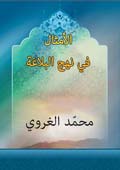الأمثال
في نهج البلاغة
محمّد الغروي
الطبعة الأولى
حقوق الطبع محفوظة للمؤلّف
1401 هـ
الناشر
انتشارات فيروزآبادي
قم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على محمد خاتم النبيّين، ووصيّه عليّ أمير المؤمنين، وآلهما المعصومين.
سبقت دراسة موضوعيّة منّا حول الأمثال المرويّة عن الإمام أمير المؤمنين (عليه السّلام)، ونحن إذ ندرس (الأمثال في نهج البلاغة) نخصّص الموضوع هنا من معطياتها السائرة ونترك التفصيل إلى كتاب (الأمثال العلويّة) .
شهر رمضان المبارك/ 1400هـ.
قم المقدسة
محمد الغروي
الأمثالُ
تنقسم الأمثال إلى:
- مثل: سائر .
- ومثل: قياسي .
و السائر: ما قالته العرب في مناسبات ثم جرى على الألسن يتمثّل به إذا وجد شيء يشارك تلك المناسبات.
و القياسي: هو تصوير يخلقه المصوّر لتوضيح فكرة عن طريق تشبيه يسمّيه البلاغيّون (التمثيل المركب)، أو إبداع يجمع بذلك بين جمال التصوير وما ينشده المتمثّل من أغراض.
بوسعنا أن نصنّف الأمثال في نهج البلاغة إلى:
- قرآنيّة، وسائرة، وقياسيّة.
وإلى:
- نثريّة وشعريّة.
وإلى:
- جاهليّة وإسلاميّة ومخضرمة.
... وإلى سواها من صنوف.
فوائد الأمثال قد استوفينا الكثير منها في مقدّمة (الأمثال النبويّة) و (البصائر) ، وكذلك تعاريف القوم لها فلا نعيد.
ثم الكتب المؤلّفة في (الأمثال العلويّة) و(الأمثال في نهج البلاغة) منها كما يلي: 100 حكمة ومثل، غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي، حكم ابن دريد، أمثال منسوبة إلى الجاحظ ، حكم الإمام علي (مجلة المشرق/ ج 5/ بيروت)، شذرات الأدب للشيخ الرئيس، نثر اللآلئ (مجموعة ثانية من فلايشر)، كلمات علي بن أبي طالب شرح الشيخ محمد عبده، أقوال أمير المؤمنين - علي بخاري، صد كلمة مولاي متقيان ترجمة روليم يول إلى الإنجليزية، ألف كلمة مجردة من شرح ابن أبي الحديد على نهج البلاغة ... وبغية الوقوف على مخطوطات ومطبوعات هذه المؤلفات يرجع إلى الجزء الأول من (تاريخ الأدب العربي) تأليف بروكلمان تحت عنوان (أمثال سيدنا علي) كما في رسالة الإسلام عدد 7 - 8 (1388هـ) الأزهر 1968م.
أمثالٌ قرآنيّةٌ :
في كلام الإمام أمير المؤمنين (عليه السّلام) آيات قرآنيّة مثليّة من نوع ما اصطلح عليه بـ (الأمثال المكنيّة) ، توفّرتْ فيها الشروط التي وضعها أرسطو لتحديد (المثل) من الإيجاز، وإصابة الغرض وغيرهما من شروط (1) ، وقد وُجد في كلامه (عليه السّلام) نيف وعشرون موضعاً تمثّل بآية قرآنية ومزَجها مزجاً متناسباً بين أبعاضه إذا نظر من لا يعلم الوحي يحسبها منه، فانظر إلى قوله (عليه السّلام):
(... فَإِنْ تَرْتَفِعْ عَنَّا وعَنْهُمْ مِحَنُ الْبَلْوَى احْمِلْهُمْ مِنَ الْحَقِّ عَلَى مَحْضِهِ وإِنْ تَكُنِ الأُخْرَى ( فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ) (2) ) (3) .
وهكذا في كلام أهل البيت (عليهم السّلام):
(وما عشت أراك الدهر عجباً، ( وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ) (4) ليت شعري إلى أيّ إسناد استندوا، وعلى أيّ عماد اعتمدوا... ( لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ ) (5) و ( بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً ) (6) ) (7) .
وفي ذلك بلاغ وأداء للرسالة، وإلفات للأنظار أنّ القرآن الكريم هو المصدر لكلّ بيان وشاهد صدق عليه، ( وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً ) (8) وأنه أحسن الحديث، ( اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً ) (9) .
____________________
(1) رسالة الإسلام 113 عدد (7 - 8).
(2) سورة فاطر الآية 8.
(3) النهج 9: 241 ط 163.
(4) سورة الرعد الآية 5.
(5) سورة الحج الآية 13.
(6) سورة الكهف الآية 50.
(7) الاحتجاج 1: 148 من خطبة الزهراء (عليها السّلام).
(8) سورة النساء الآية122.
(9) سورة الزمر الآية 23.
ونحن نذكر خمس آيات من نيف وعشرون مقتصرين على بيان بعض وجهات النظر منها وبعدها نأتي على نبذة من أمثال سائرة، وغير سائرة، إن شاء الله تعالى.
1 - ( عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ) (1) .
وقبلها: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ) .
ختم الإمام علي (عليه السّلام) بها خطبة له أوّلها:
(لا يَشْغَلُهُ شَأْنٌ ولا يُغَيِّرُهُ زَمَانٌ... ولَو أَنَّ النَّاسَ حِينَ تَنْزِلُ بِهِمُ النِّقَمُ وتَزُولُ عَنْهُمُ النِّعَمُ فَزِعُوا إِلَى رَبِّهِمْ بِصِدْقٍ مِنْ نِيَّاتِهِمْ ووَلَهٍ مِنْ قُلُوبِهِمْ لَرَدَّ عَلَيْهِمْ كُلَّ شَارِدٍ، وأَصْلَحَ لَهُمْ كُلَّ فَاسِدٍ... ولَئِنْ رُدَّ عَلَيْكُمْ أَمْرُكُمْ إِنَّكُمْ لَسُعَدَاءُ ومَا عَلَيَّ إِلاَّ الْجُهْدُ ولَو أَشَاءُ أَنْ أَقُولَ لَقُلْتُ: ( عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ) ) (2) .
تمثّل بالآية (عليه السّلام) الدالّة على سعة عفوه تعالى عما يزاوله الناس من ظلم أنفسهم ومعصيته على ما صدر من أصحابه من خلاف عليه إن عادوا عن غيّهم فإنّ الله عفّو عما سلف من ذلك، وأنّ العباد إذا تابوا لردّ عليهم كلّ ما فات منهم ولسعدوا برجوعهم إلى الله تعالى، وكذلك أصحابه يشير إلى عفوه (عليه السّلام) عما سلف منهم لأنّ عفوه من عفو الله تعالى.
زعم بعض أنّه (عليه السّلام) يريد العفو عمّن منعه الخلافة بتمثّله بالآية (3) ، وهو مردود؛ لأنّ الخلافة منصب إلهيّ ليس من قبيل الحق
____________________
(1) سورة المائدة: الآية 95.
(2) النهج 10: 58 - 61 - ط 179.
(3) المصدر.
القابل للإسقاط والعفو، بل من نوع الحكم غير القابل لذلك. على أنّ العفو عما سلف له شرط هو عدم الإصرار على العصيان وعدم العود إليه، لقوله تعالى: ( وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ) (1) ( إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ) (2) ( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ) (3) إذ مع الإصرار لم ينفع الاستغفار، ولا وجه له شرعاً وعقلاً، ومن المعلوم أنّ غصب الخلافة قد كان من أشدّ التعمّد من غير ندم منهم.
____________________
(1) سورة المائدة الآية 95.
(2) سورة الأنفال الآية 38.
(3) سورة البقرة الآية 275.
2- ( وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ) (1) .
وقبلها: ( وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ * مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ) ، نزلت في قوم لوط لأجل عمل اللواط، أمطرت عليهم حجارة سجّيل، وهو طين متحجّر، معرّب من: (سنگ گل) عذاب كلّ لائط، بل كلّ ظالم هو معرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعة (2) .
تمثّل بها الإمام (عليه السّلام) وطبّقها على معاوية وعشيرته من أخيه وخاله وجدّه وأبيه ومن حذا حذوه في كتاب له، وهو من محاسن الكتب جواباً لكتاب لمعاوية:
(... وأَنَا مُرْقِلٌ نَحْوَكَ فِي جَحْفَلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ والأنْصَارِ والتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، شَدِيدٍ زِحَامُهُمْ، سَاطِعٍ قَتَامُهُمْ، مُتَسَرْبِلِينَ سَرَابِيلَ الْمَوْتِ، أَحَبُّ اللِّقَاءِ إِلَيْهِمْ لِقَاءُ رَبِّهِمْ، وقَدْ صَحِبَتْهُمْ ذُرِّيَّةٌ بَدْرِيَّةٌ وسُيُوفٌ هَاشِمِيَّةٌ، قَدْ عَرَفْتَ مَوَاقِعَ نِصَالِهَا فِي أَخِيكَ وخَالِكَ وجَدِّكَ وأَهْلِكَ ( وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ )) (3) .
ومعاوية رأس الظلم والطغيان وكذا كلّ من ينتسب إليه.
والإمام (عليه السّلام) إذ تمثّل بالآية لهؤلاء الظالمين، معاوية وأذنابه، أعاد الضمير فيها - أي ضمير و ( هِيَ ) - إلى السيوف الهاشميّة المذكورة في كلامه (عليه السّلام) وفي الآية عائدة إلى الحجارة وهي مضرب التمثيل الذي يقصده، فإرجاع الضمير وإن كان في الآية إلى الحجارة
____________________
(1) سورة هود الآية 83.
(2) تفسير الصافي 1: 805.
(3) النهج: 15: 181 - 184 ك 28.
وفي كلامه (عليه السّلام) إلى السيوف الهاشميّة، لكن يشترك فيهما كلّ ظالم مهما كان نوعه، وهما عذاب ونقمة للظالمين بأسرهم، ولَكَ أن تتمثّل بالآية في غير الحجارة والسيف إذا أصبتَ ما تقصده، شأن المثل أينما حلّ ونزل، مع رعاية الناحية المشتركة بين أموره وما من أجله مثّل.
3- ( وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ) (1) .
وقبلها: ( إِنْ تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ) ، أي ولا يخبرك بالأمر مخبر مثل خبير به أخبرك، وهو الله سبحانه، فأنّه الخبير به على الحقيقة دون سائر المخبرين، والمراد به: الإخبار عن حال آلهتهم ونفي ما يدّعون (2) .
وطبّقها الإمام (عليه السّلام) في آخر كلام له على نفسه الشّريفة وأنّه الخبير المخبِر أصحابه وغيرهم من أيّ إنسان غافل بحالات ترد عليهم وما يئول إليه الأمر، حيث قال (عليه السّلام): (... فَأَفِقْ أَيُّهَا السَّامِعُ مِنْ سَكْرَتِكَ... وضَعْ فَخْرَكَ واحْطُطْ كِبْرَكَ، واذْكُرْ قَبْرَكَ فَإِنَّ عَلَيْهِ مَمَرَّكَ، وكَمَا تَدِينُ تُدَانُ، وكَمَا تَزْرَعُ تَحْصُدُ... فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ أَيُّهَا الْمُسْتَمِعُ والْجِدَّ الْجِدَّ أَيُّهَا الْغَافِلُ: ( وَلاَ يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ) ) (3) ، ومثل الآية قولهم: (على الخبير سقطت).
(سأل حارثة بن عبد العزيز العامري مالك بن حني العامري - وكانت بينهما منافرة - عن أوّل من قرعت له العصا؟ فقال: (على الخبير سقطت وبالحليم أحطت) وهو أوّل من قاله. ويسأل الحسينُ بن عليّ (عليهما السّلام) الفرزدق عن أهل الكوفة، فقال: (على الخبير سقطت، قلوب الناس معك وأسيافهم مع بني أميّة... والأمر ينزل بعد الأمر من السّماء)، يضرب للعالم بالأمر، قال ربيعة الأسدي:
____________________
(1) سورة فاطر الآية 14.
(2) تفسير الصافي 2: 458.
(3) النّهج 9: 158 الخطبة 153.
وسائلةٍ تُسائلُ عن أَبيها |
فقلت لها وَقَعْتِ على الخَبيرِ |
|
رأيتُ أَباكِ وقد أَطْلى ومالت |
عليه القَشْعَمان مِن النُّسورِ) (1) |
والآية فيها من البلاغة ما لا يملكها المثل السائر.. وكذا سائر آيات الأمثال القرآنية.
____________________
(1) المستقصي 2: 164، والقشعمان: الذّكر منها، ومثل المثل: على الجازي هبطت. انظر: مجمع الأمثال 2: 36 حرف العين.
4- ( وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ) (1) .
تمثّل (عليه السّلام) بها في آخر خطبة له في ذمّ أهل العراق:
(أَمَّا بَعْدُ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ فَإِنَّمَا أَنْتُمْ كَالْمَرْأَةِ الْحَامِلِ حَمَلَتْ فَلَمَّا أَتَمَّتْ أَمْلَصَتْ.. ولَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: عَلِيٌّ يَكْذِبُ! قَاتَلَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى! فَعَلَى مَنْ أَكْذِبُ أَعَلَى اللَّهِ فَأَنَا أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِهِ... كَلا واللَّهِ، لَكِنَّهَا لَهْجَةٌ غِبْتُمْ عَنْهَا ولَمْ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهَا، وَيْلُ أُمِّهِ (2) كَيْلاً بِغَيْرِ ثَمَنٍ لَو كَانَ لَهُ وِعَاءٌ، ( وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ) ) (3) .
تهديداً لهم بما يصيبهم من بني أمية والحجاج وأضراب هؤلاء من ظلم وتقتيل حيث استحقوا ذلك من جرّاء خلافهم على الإمام (عليه السّلام)، فضرب لهم مثلاً بالمرأة الحامل وقد تمّ شهورها وأوشكت أن تضع أجهضت نفسها فسقط الجنين ميتاً، وكذلك حالهم؛ لعدم استقامتهم على دين الإسلام، كيف وهم يحملون لإمامهم العداء وفحش القول حتى نسبوا إليه الكذب والبهتان؟!
يقول (عليه السّلام) لهم: كيف أكون كاذباً وأنا أوّل من آمن بالله والرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم)؟! ولكنّكم - يا أهل العراق - أنتم غبتم عن اللهجة الصادقة وفقدتموها فنسبتم ذلك إليّ، وإنّما كلتُ لكم المعارف ومكارم الأخلاق كيلاً بلا عوض، لا أطلب عليها أجراً، لو كان لها وعاء من صدور نقيّة وقلوب طاهرة، وستعلمون نبأ كلّ ذلك وجزاء عملكم تجاه ما عانيتُ.. أمر محتّم.
ومن المناسبة الشديدة لما هو عليه (عليه السّلام) ما جاء قبل
____________________
(1) سورة ص الآية 88.
(2) ذكرناه في الأمثال السائرة.
(3) النهج 6: 127 ط 70.
الآية: ( قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُتَكَلِّفِينَ ) ، قد شابهت حالةُ الإمامِ النبيَّ (ص) مع القوم تماماً.
5 - ( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى ) (1) .
تمثّل بها الإمام (عليه السّلام) لمن اعتبر من خلق السماوات والأرض وخشي من الله تعالى في خطبة له بهذا الصدد:
(وكَانَ مِنِ اقْتِدَارِ جَبَرُوتِهِ، وبَدِيعِ لَطَائِفِ صَنْعَتِهِ، أَنْ جَعَلَ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ الزَّاخِرِ الْمُتَرَاكِمِ الْمُتَقَاصِفِ يَبَساً جَامِداً، ثُمَّ فَطَرَ مِنْهُ أَطْبَاقاً فَفَتَقَهَا سَبْعَ سَمَاوَاتٍ بَعْدَ ارْتِتَاقِهَا... فَسُبْحَانَ مَنْ أَمْسَكَهَا بَعْدَ مَوَجَانِ مِيَاهِهَا وأَجْمَدَهَا بَعْدَ رُطُوبَةِ أَكْنَافِهَا... ( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى ) ) (2) .
والآية نزلت في فرعون ومن شاكله في دعواه الباطلة حيث حكى عنه: ( فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى * فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الآخِرَةِ وَالأُولَى ) (3) .
ومن ذلك يظهر وجه الفرق لمورد الآية وما يقصده الإمام (عليه السّلام)، ولكنّ الذي يجمع بينهما الناحية المشتركة المسبّبة لخشية المعتبر إذا نظر بعين الاعتبار إلى فرعون وما حلّ به من النكال خاف أن يكون كما كان، كما أنه لو تفكّر في هذا الصنع العجيب الذي تحار فيه العقول، وهو إيجاد السماوات والأرض من الماء الذي جعل كلّ شيء حيّ منه، أتته الخشية الموجبة للقيام بالعبوديّة له تعالى. فالمشار إليه بكلمة ( ذَلِكَ ) في الآية شيء وفي كلام الإمام (عليه السّلام) شيء، والجامع بينهما إيراث الخوف والخشية؛ وهو الغرض من التمثيل بالآية، كما أنّ الاعتبار بهذا أو بذاك والتفكير فيهما العلة المشتركة في تحقيق
____________________
(1) سورة النازعات الآية 26.
(2) النهج 11: 51 ط 204.
(3) سورة النازعات الآية 24 - 25.
الغرض المنشود، ومن هنا ساغ التمثيل للجميع إذا روعيت العلّة المحقّقة للغرض في ذلك.
الأمثال السائرة، وغير السائرة
الموزّعة على أبواب الحروف:
باب الهمزة:
الهمزة مع الألف:
1 - آخرُ الدّواء الكيّ (1) .
تمثّل به (عليه السّلام) في كتاب له جواباً لقوم سألوه عقاب من أجلب على عثمان بعد ما بويع: (يَا إِخْوَتَاهْ إِنِّي لَسْتُ أَجْهَلُ مَا تَعْلَمُونَ... وسَأُمْسِكُ الأمْرَ مَا اسْتَمْسَكَ، وإِذَا لَمْ أَجِدْ بُدّاً فَـ "آخِرُ الدَّوَاءِ الْكَيُّ").
(لأنه إنّما يقدم عليه بعد أن لا ينفع كلّ دواء... أي إذا أعضل وأبى قبول كلّ دواء حُسم بالكيّ) (2) ، وقيل: (آخر الدواء الكيّ). وردّ أنّه من غلط العامّة إذ الكيّ ليس من الداء ليكون آخره، قيل: أوّل من قال المثل لقمان بن عاد في قصّة امرأة غازلت رجلاً تزعمه أخاها حتى لقى لقمان زوجها - اسمه هانئ - يسوق إبله ويقول:
روحي إلى الحيّ فإنّ نفسي |
رهينة فيهم بخير عرس |
|
حسّانة المقلة ذات أنس |
لا يشتري اليوم لها بأمس |
فهتف به لقمان: يا هانئ! وقال:
يا ذا البجاد (3) الحلكة (4) |
والزوجة المشتركة |
|
عشّ رويداً إبلكه |
لست لمن ليس لكه |
قال هانئ: نور نور لله أبوك؟ قال لقمان: عليّ التنوير وعليك التغيير، مررت بها تغازل رجلاً زعمته أخاها. قال: فما الرأي؟ قال: أن تقلب الظهر
____________________
(1) النهج: 9: 291 ط 169.
(2) المستقصي 1: 3.
(3) البجاد: الكساء.
(4) الحلك: الأسود.
بطناً حتى يستبين لك الأمر. قال: أعالجها بكيّة توردها المنيّة. قال: (آخر الدواء الكيّ)، يضرب فيمن يستعمل في أوّل ما يجب استعماله في آخره وفي إعمال المخاشنة مع العدوّ إذا لم يجدِ معه اللين والمداراة (1) .
صدقت القصّة أم لا فإنّه يساعده الاعتبار.
____________________
(1) المستقصي 1: 53 [نقلٌ بتلخيص].
الهمزة مع التّاء
2 - اتباع الكلب للضرغام يلوذ إلى مخالبه (1) .
من كتاب له (عليه السّلام) إلى عمرو بن العاص:
(فَإِنَّكَ قَدْ جَعَلْتَ دِينَكَ تَبَعاً لِدُنْيَا امْرِئٍ ظَاهِرٍ غَيُّهُ، مَهْتُوكٍ سِتْرُهُ، يَشِينُ الْكَرِيمَ بِمَجْلِسِهِ، ويُسَفِّهُ الْحَلِيمَ بِخِلْطَتِهِ. فَاتَّبَعْتَ أَثَرَهُ، وطَلَبْتَ فَضْلَهُ "اتِّبَاعَ الْكَلْبِ لِلضِّرْغَامِ يَلُوذُ بِمَخَالِبِهِ"، ويَنْتَظِرُ مَا يُلْقَى إِلَيْهِ مِنْ فَضْلِ فَرِيسَتِهِ، فَأَذْهَبْتَ دُنْيَاكَ وآخِرَتَكَ، ولَوْ بِالْحَقِّ أَخَذْتَ أَدْرَكْتَ مَا طَلَبْتَ...).
إذا دنئت نفس المرء غربت عنها المكارم الإنسانيّة والأخلاق المرضيّة، ورسخت فيها أضدادها واستحكمت خِلال البهائم والسباع فيها إلى الغاية، فإذا استولى الغضب عليها فأسدٌ مفترسٌ لا همّ له سوى الافتراس، وإذا ملكها الطمع فصاحبها كلب لائذ ينتظر ما يلقى إليه، أو الاحتيال فثعلب.. وهلمّ جرّاً في كلّ خصلة تختصلها السباع والحيوانات، تنكشف لذوي البصائر من الناس فضلاً عن أمير المؤمنين الذي يرى الأشياء كما هي. إذا وصف شيئاً منحه نعوته الجديرة به؛ لأنّه (عليه السّلام) الحَكَم العدْل الذي يعطي كلّ ذي حق حقّه، فمن نظر إلى معاوية وابن العاص وجد الخلال التي بيّنها الإمام (عليه السّلام) من الفسق وشين الكريم وتسفيه الحليم فيهما، وأنّهما يجريان مجرى الكلاب والأسود عند الفريسة، تابعة متبوعة.
وعن ابن مزاحم في كتاب صفّين بلفظ:
____________________
(1) النهج 16: 160، 39/ك.
(أمّا بعد فإنّك تركت مروءتك لامرئ فاسق مهتوك ستره، يشين الكريم بمجلسه ويسفّه الحليم بخلطته، فصار قلبك لقلبه تبعاً كما قيل: (وافق شن طبقة) (1) . فسلبك دينك وأمانتك ودنياك وآخرتك... فصرت كالذئب يتبع الضرغام إذا ما لليل دجى أو أتى الصبح، يلتمس فاضل سؤره وحوايا فريسته، ولكن لا نجاة من القدر...) (2) .
____________________
(1) من الأمثال السائرة: مجمع الأمثال 2: 359 حرف الواو.
(2) شرح النهج 16: 163.
الهمزة مع الحاء
3- أحببْ حبيبك هوناً ما ، عسى أن يكون بغيضك يوماً ما (1) ، وأبغض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما .
من كلمات الإمام (عليه السّلام) الحكميّة، عدّه أبو هلال العسكري من الأمثال في جمهرته ، وقال: المثل لأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (كرّم الله وجهه). وهوناً أي قصداً غير إفراط، وهو من قول النمر بن تولب:
وَأَحبِب حَبيبَكَ حُبّاً رُوَيداً |
لئلاّ يَعولُكَ أن تَصْرِما |
|
وَأَبغض بَغيضكَ بُغضاً رُوَيداً |
إِذا أَنتَ حاوَلتَ أَن تَحكُما |
ومن أجود ما قيل في هذا المعنى قول بعضهم: (لا تكن مكثراً ثمّ تكون مقلاّ فيعرف سرفك في الإكثار وجفاؤك في الإقلال) (2) .
قال الشارح:
(الهَون بالفتح: التأني، والبغيض: المبغض. و خلاصة هذه الكلمة: النهي عن الإسراف في المودّة والبغضة؛ فربّما انقلب مَن تودّ فصار عدّواً، وربّما انقلب مَن تعاديه فصار صديقاً... وقال بعض الحكماء: توقّ الإفراط في المحبّة فإنّ الإفراط فيها داعٍ إلى التقصير منها، ولأن تكون الحال بينك وبين حبيبك نامية أولى من أن تكون متناهية... وقال الشاعر:
أَحبِب إِذا أَحبَبتَ حُبّاً مُقارِباً |
فَإِنَّكَ لا تَدري مَتى أَنتَ نازِعُ |
|
وَأَبغِض إِذا أَبغَضتَ بُغضاً مباينٍ |
فَإِنَّكَ لا تَدري مَتى أَنتَ راجِعُ |
وقال عديّ بن زيد:
____________________
(1) النهج 19: 156، 274/ح.
(2) على هامش مجمع الأمثال 1: 156 [نقل بتلخيص وتصرُّف].
ولا تأمنن من مبغض قرب داره |
ولا من محبّ أن يملّ فيبعد) (1) |
وقد قيل: صرعة الاسترسال لا تستقال، نعم إذا كان الحبّ مع الله (عَزَّ وجلَّ) فأحبب حبّاً إلى الغاية بدون إقلال، بل إلى حدّ العشق، وهو الحبّ المفرط وأبغض الشيطان والنّفس وما يصدّك عنه تعالى.
____________________
(1) شرح النهج 19: 156.
الهمزة مع اللاّم
4 - الآن رجع الحقّ إلى أهله (1) .
(لَا يُقَاسُ بِآلِ مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وآله) مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحَدٌ، ولَا يُسَوَّى بِهِمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَيْهِ أَبَداً، هُمْ أَسَاسُ الدِّينِ، وعِمَادُ الْيَقِينِ. إِلَيْهِمْ يَفِيءُ الْغَالِي، وبِهِمْ يُلْحَقُ التَّالِي، ولَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَايَةِ، وفِيهِمُ الْوَصِيَّةُ والْوِرَاثَةُ "الْآنَ إِذْ رَجَعَ الْحَقُّ إِلَى أَهْلِهِ" ونُقِلَ إِلَى مُنْتَقَلِهِ).
هذا فصل من فصول خطبة له (عليه السّلام) بعد انصرافه من صفّين، وفي معنى المثل المذكور ما جاء من أمثال العرب:
( عاد السهم إلى النزعة: أ ي رجع الحق إلى أهله. والنزعة الرماة من (نزع في قوسه) أي رمى، فإذا قالوا: (عاد الرمي على النزعة) كان المعنى عاد عاقبة الظلم على الظالم، ويكنّى بها عن الهزيمة تقع على القوم) (2) .
ومنها: ( عاد الأمر إلى نصابه: يضرب في الأمر يتولاّه أربابه) (3) .
يريد (عليه السّلام) بذلك رجوع الخلافة بعد اغتصابها إليه أيّام خلافته، وتأوّل الكلام المعتزليُ بما يأباه العقل والنقل، قال:
(وهذا يقتضي أن يكون فيما قبل في غير أهله، ونحن نتأوّل ذلك على غير ما تذكره الإماميّة ونقول: إنّه (عليه السّلام) كان أولى بالأمر وأحقّ لا على وجه النصّ على الخلافة، بل على وجه الأفضليّة... لكنّه
____________________
(1) النهج 1: 131 - 139، 2/ط.
(2) مجمع الأمثال 2: 18 حرف العين.
(3) المصدر 2: 35.
ترك حقّه لِمَا علمه من المصلحة...) (1) .
ليتني دريت ما حمل المعتزلي على سحق عقله حتى يتناقض في القول! إن كان (عليه السّلام) كما يقول: إنّه الأحقّ بالخلافة من جميع المسلمين بحكم العقل، وإنه أفضل البشر، فكيف يهمل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) النصّ عليه حتّى يختاروا من هو أدنى؟! وهل هذا إلاّ تغرير منفيّ عنه (صلّى الله عليه وآله وسلّم)؟! وهل يشكّ عربيّ في معنى (رجع الحق إلى أهله) أنّ فيما قبله غير أهل له؟! والكلام المتقدم ينصّ على انحصار الوصاية والوراثة، وهي الخلافة المنصوصة. قال المعتزلي: (ولسنا نعني بالوصيّة النصَ على الخلافة، ولكن أمور أخرى) (2) . نعم، أمور أخرى حملتك على ذلك.. والحديث ذو شجون.
____________________
(1) شرح النهج 1: 140.
(2) المصدر.
الهمزة مع الميم
5 -
أمرتكم أمري بمنُعَرِجِ اللّوى |
|
فلم تستبينوا النُّصحَ إلاّ ضُحى الغد (1) |
من أخطر خطبة له (عليه السّلام) بعد التحكيم: (... فَأَبَيْتُمْ عَلَيَّ إِبَاءَ الْمُخَالِفِينَ الْجُفَاةِ، والْمُنَابِذِينَ الْعُصَاةِ، حَتَّى ارْتَابَ النَّاصِحُ بِنُصْحِهِ، وضَنَّ الزَّنْدُ بِقَدْحِهِ، فَكُنْتُ أَنَا وإِيَّاكُمْ كَمَا قَالَ أَخُو هَوَازِنَ:
«أَمَرْتُكُمْ أَمْرِي بِمُنْعَرَجِ اللِّوَى |
فَلَمْ تَسْتَبِينُوا النُّصْحَ إِلَّا ضُحَى الْغَدِ») |
(وأخو هوازن صاحب الشعر هو دريد بن الصَمَّة، والأبيات مذكورة في الحماسة ، وأوّلها:
نَصَحتُ لِعارِضٍ وَأَصحابِ عارِضٍ |
وَرَهطِ بَني السَوداءِ وَالقَومُ شُهَّدي |
|
فقلتُ لَهُم: ظُنّوا بِأَلفَي مُدَجَّجٍ |
سَراتُهُمُ في الفارِسيِّ المُسَرَّدِ |
|
أَمَرْتُكُمْ أَمْرِي بِمُنْعَرَجِ اللِّوَى |
فَلَمْ تَسْتَبِينُوا النُّصْحَ إِلَّا ضُحَى الْغَدِ |
|
فَلَمّا عَصوني كُنتُ مِنهُم وَقَد أَرى |
غِوايَتَهُم وَأَنَّني غَيرُ مُهتَدِ |
|
وَهَل أَنا إِلّا مِن غَزِيَّةَ إِن غَوَت |
غَوَيتُ وَإِن تَرشُد غَزيَّةُ أَرشَدِ) (2) |
حادثة التحكيم، عند مخالفة أصحابه (عليه السّلام)، يعرف عظمها من كلامه حيث يقول: (فَأَبَيْتُمْ عَلَيَّ إِبَاءَ الْمُخَالِفِينَ الْجُفَاةِ...) والكلّ يدري ما يصنع المخالف الجاف والمنابذ العاصي على أميره، وهو ناصحه حتّى ارتاب بنصحه.
وقوله (عليه السّلام): (وضَنَّ الزَّنْدُ بِقَدْحِهِ) أي (لم يقدح لي بعد ذلك رأي صالح لشدّة ما لقيت منكم من الإباء والخلاف والعصيان... لأنّ
____________________
(1) النهج 2: 204، 35/ط.
(2) شرح النهج 2: 205.
المشير الناصح إذا اتّهم واستغشّ، عمى قلبه وفسد رأيه) (1) .
نعم، بالإضافة إلى الإمام لم يَعْمَ قلبه ولم يَفسد رأيه ويصبر على البلوى والأمر بطبعه الأوّلي كذلك.
____________________
(1) المصدر.
الهمزة مع الياء
6 - أَيَادِيَ سَبَأ (1) .
من كلام له (عليه السّلام): (... فَمَا آتِي عَلَى آخِرِ قَوْلِي حَتَّى أَرَاكُمْ مُتَفَرِّقِينَ "أَيَادِيَ سَبَأ"...).
اختُلف في أنّ المثل إسلاميّ، أصله قوله تعالى: ( وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ) (2) في قصّة أهل سبأ وتفرّقهم المذكورة في القرآن الكريم وروايات أهل البيت (عليهم السّلام)، أو جاهليّ كما ذهب إليه الدكتور صفا خلوصي؛ لأنّ سبأ وجدت قبل الإسلام (3) ؟ وهل وجود قوم سبأ قبل الإسلام يصيّر المثل جاهليّاً أو لابدّ من ضربه فيه لتلك الحالة لا وجود الحالة؟
قال ابن أبي الحديد:
(وأيادي سبأ مثل يضرب لمتفرّقين، وأصله قوله تعالى عن أهل سبأ: ( وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ) . وسبأ مهموز، وهو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. ويقال: ذهبوا أيدي سبأ، وأيادي سبأ. الياء ساكنة وكذلك الألف، وهكذا نقل المثل: أي ذهبوا متفرّقين، وهما اسمان جعلا واحداً مثل: معد كرب) (4) .
يضرب المثل المذكور لبيان تفرّق الجمع المقصود بهم وللدعاء عليهم، أي لا تفارقهم الفرقة، ولعلّ الثاني أولى بكلام الإمام (عليه السّلام) ليكون جملة (أيادي سبأ) دعاء عليهم، إلاّ أنّ ظهور الجملة في تشبيه تفرّق أصحابه (عليه السّلام) عند خطابه بتفرّق قوم سبأ يردّ الدعاء المذكور فتدبّر جيداً.
____________________
(1) النهج 7: 70، 96/ط.
(2) سبأ: 19.
(3) دراسة في الأمثال العربيّة القديمة، انظر: هامش رسالة الإسلام عدد 7 - 8/116.
(4) شرح النهج 7: 74 - 75.
ولقد كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) يعاني من تفرّق الأصحاب، والفُرقة هي السبب لإبادة الجماعة، وقد نهى الله جلّ جلاله عنها وأمر بالاعتصام بقوله تعالى: ( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا ) (1) ، وهو (عليه السّلام) الحبل المتين الذي أمر العباد بالتمسّك به. ولا ينافي أن يكون حبل الله القرآن أو الرسول (صلّى الله عليه وآله)، فإنّ كلّ ذلك شيء واحد يدعو إلى الواحد وهو الله تعالى.
____________________
(1) سورة آل عمران الآية 103.
7- إِيّاك وما يُعتذَرُ منهُ (1) .
جاء المثل في كتاب له (عليه السّلام) إلى قثم بن عبّاس، وهو عامله على مكّة.
قال الميداني بعد المثل المذكور: (أي لا ترتكب أمراً تحتاج فيه إلى الاعتذار منه) (2) .
وهو من الأمثال المرسلة وإن لم يرسله الإمام (عليه السّلام).
ثم الاعتذار، ممّا يوجبه، إنّما هو من صنع الجاهل، حيث يقدم على ما لا يدري مغبّته ولا حسنه من قبحه أو خيره من شرّه، فإذا انكشف الحال ندم واعتذر. أمّا العاقل، فلا يترأّى قبل أن يتروّى، ولا يقدم على عمل إلاّ بعد التثبّت والعلم بمغبّته. وقد قالوا المثل: (شر الرأي الدُّبري: والدّبري الذي يجيء بعد ما يفوت الأمر) (3) .
ومن أجله رُغّبت المشورة وأُمر الجاهل بالسؤال من أهل الذكر في الكتاب والسنّة في أمور الدّين والدّنيا، والمستبدّ برأيه هالك، والتثبّت في كلّ شيء حتّى لا يقع فيما لا يحمد عقباه، وعدم جواز الأخذ بنبأ الفاسق إلاّ بعد التبيّن؛ لئلاّ يصيب إنساناً بجهالة فيصبح على ما فعل نادماً كما قال تعالى: ( إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ) (4) . والمورد لا يخصَّص فيجري فيما ماثله من نوعه.
ثم المثل يشمل كلّ ما ذكر وما لم يذكر من الموارد الّتي تورث
____________________
(1) النهج 16: 138، 33/ك.
(2) مجمع الأمثال 1: 44 حرف الهمزة.
(3) الجمهرة على هامش مجمع الأمثال 1: 13 حرف الشين.
(4) سورة الحجرات الآية 6.
الاعتذار بعدها، سواء كان من قول أو عمل، بل مطلق السّكون والحركة التي لا يخلو منهما الإنسان. فلابدّ من التفكر فيه أوّلاً، فإن عَلِم أنّ في ذلك رشداً أقدم، أو غيّاً أحجم عنه. ويقف عند الشبهة لئلاّ يهلك من حيث لا يعلم كما جاء فيه حديث التثليث: (الأمور ثلاثة: أمر بيّن رشده فيتّبع، وأمر بيّن غيّه فيجتنب، وشبهات بين ذلك، فمن أخذ بها هلك من حيث لا يعلم ومن وقف نجا) (1) ما مضمون الحديث فراجع.
____________________
(1) الوسائل 18: 114.
باب الباء
الباء مع العين
8 - بعدَ اللُتَّيّا والَّتي (1) .
قال (عليه السّلام) في خطبة له: (فَإِنْ أَقُلْ يَقُولُوا حَرَصَ عَلَى الْمُلْكِ! وإِنْ أَسْكُتْ يَقُولُوا جَزِعَ مِنَ الْمَوْتِ! هَيْهَاتَ! "بَعْدَ اللَّتَيَّا والَّتِي" واللَّهِ لَابْنُ أَبِي طَالِبٍ آنَسُ بِالْمَوْتِ مِنَ الطِّفْلِ بِثَدْيِ أُمِّه ِ...).
اللُّتيا تصغير الّتي، كما أنّ اللُّذيا تصغير الّذي، وفيالقاموس : بفتح اللام المشدّدة وضمّها.
و((هَيْهَاتَ): لظنّهم فيه الجزع. أي: أَبَعْدَ اللّتيا والّتي أجزعُ؟! أبَعْدَ أن قاسيتُ الأهوال، الكبار والصغار، ومُنيت بكلّ داهية عظيمة وصغيرة؟! فاللّتيا للصغيرة، والّتي للكبيرة) (2) .
(بعد اللّتيا والّتي): (هما الداهية الكبيرة والصغيرة، وكنّى عن الكبيرة بلفظ التصغير تشبيهاً بالحيّة فإنّها إذا كثر سمّها صغرت؛ لأنّ السمّ يأكل جسدها. وقيل: الأصل فيه أنّ رجلاً من حديس تزوّج امرأة قصيرة، فقاسى منها الشدائد وكان يعبّر عنها بالتصغير، فتزوّج امرأة طويلة فقاسى منها ضعف ما قاسى من الصغيرة، فطلّقها وقال: بعَدْ اللُّتيا والّتي لا أتزوّج أبداً، فجرى ذلك على الداهية. وقيل: إنّ العرب تصغّر الشيء العظيم كالدهيم واللهيم وذلك منهم رمز) (3) .
وهو مثل سائر يضرب لأمرين داهيتين إحداها أدهى من الأخرى.
____________________
(1) النهج 1: 213، 5/ط.
(2) شرح النهج 1: 214 [نقل بتلخيص وتصرُّف].
(3) مجمع الأمثال 1: 92 حرف الباء.
يريد (عليه السّلام) بالقول مطالبة الخلافة من الشيخين. إذا طالبهما بها، قال الناس حرص على الملك الدنيوي! أترى حين تقمّصاها لمَ لا يقولوا لهما حرصتما على الملك ويقولون ذلك لأمير المؤمنين (عليه السّلام)؟! وهو على حدّ أن يقولوه لرسول الله (صلّى الله عليه وآله): إنّ النبوّة والخلافة كلتيهما أمر سماوي.
باب التاء
التّاء مع القاف
9 - تَقْصِرُ دُونَها الأَنْوَقُ، وَيُحاذى العَيُّوق ُ (1) .
من كتابه (عليه السّلام) إلى معاوية:
(... وقَدْ أَتَانِي كِتَابٌ مِنْكَ ذُو أَفَانِينَ مِنَ الْقَوْلِ، ضَعُفَتْ قُوَاهَا عَنِ السِّلْمِ، وأَسَاطِيرَ لَمْ يَحُكْهَا مِنْكَ عِلْمٌ ولَا حِلْمٌ، أَصْبَحْتَ مِنْهَا كَالْخَائِضِ فِي الدَّهَاسِ والْخَابِطِ فِي الدِّيمَاسِ، وتَرَقَّيْتَ إِلَى مَرْقَبَةٍ بَعِيدَةِ الْمَرَامِ نَازِحَةِ الْأَعْلَامِ "تَقْصُرُ دُونَهَا الْأَنُوقُ ويُحَاذَى بِهَا الْعَيُّوقُ").
في كلامه (عليه السّلام) أكثر من تمثيل يظهر بعد شرح مفرداته:
أفانين القول: أساليبه المتنوّعة.
و ضعف قوى الأفانين عن السّلم: أي الإسلام، أي عدم صدورها عن مسلم، حيث طَلَبَ تولّيه العهد وإبقائه بالشام رئيساً.
و الأساطير، جمع أسطورة: الأباطيل.
حوكها : نظها.
و الدِّهاس (بالكسر): جمع دهس و(بالفتح) مفرد، وهو المكان السهل، ليس هو بتراب ولا طين.
و الدِّيماس (بالكسر): السر المظلم تحت الأرض.
و المرقبة : الموضع العالي يراقب عليه.
و الأعلام، جمع علم: ما يهتدى به في الطرقات.
والأنوق (بالفتح): (طائر، وهو الرخمة، وفي المثل: أعزّ من بيض الأنوق (2) ؛ لأنّها تُحرزِه فلا يظفر به أحد).
والعيّوق: كوكب فوق زحل في العلو.
أي: أنت بكتابك المشتمل على دعاوٍ باطلة لا تصدر عن مسلم، ولا يحكي عن علم وحلم كاتبه، لستَ إلاّ كالخائض في أرض رخوة تقوم وتقع،
____________________
(1) النهج 18: 22، 65/ك.
(2) مجمع الأمثال 2: 44 حرف العين [ هذا المثل ورد في مجمع الأمثال كما أشار المؤلف، ولكن جميع العبارة، وقد وضعناها بين قوسين، هي لابن أبي الحديد المدائني في شرح النهج ].
والخابط في نفق مظلم لا يهتدي الطريق، سَمَتْ همتَّك إلى الخلافة وهي منك بموضع مرتفع عال لا سبيل إليه، ولا أعلام تَهتدي بها، وهي كالرخمة الّتي لا يُظفر ببيضها، والكوكبِ الذي فوق الكواكب كلّها.. فكيف ترومها؟! (1)
ضربت هذه الأمثال لبُعد معاوية عن الخلافة الّتي يريدها، ويضرب المثل المذكور لقصور طالب الشيء. وفي معنى المثْلَين قولهم: (دونه بيض الأنوق) و (دونه العيّوق) (2) .
____________________
(1) تلخيص من شرح النهج 18: 25 - 27.
(2) مجمع الأمثال 1: 265 حرف الدال.
باب الحاء
الحاء مَعَ الدّال
10- حَدْوَ الزّاجِرِ بِشَوْلِه (1) .
قال (عليه السّلام): (... عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ الدَّهْرَ يَجْرِي بِالْبَاقِينَ كَجَرْيِهِ بِالْمَاضِينَ: لا يَعُودُ مَا قَدْ وَلَّى مِنْهُ، ولا يَبْقَى سَرْمَداً مَا فِيهِ. آخِرُ فَعَالِهِ كَأَوَّلِهِ. مُتَشَابِهَةٌ أُمُورُهُ، مُتَظَاهِرَةٌ أَعْلامُهُ، فَكَأَنَّكُمْ بِالسَّاعَةِ تَحْدُوكُمْ "حَدْو الزَّاجِرِ بِشَوْلِهِ").
قال ابن الأثير: (وهي الناقَةُ التي شالَ لبَنُها: أي ارْتَفع. وتُسمَّى الشَّوْلَ: أي ذات شَوْلٍ؛ لأنه لم يَبْقَ في ضَرْعها إلاّ شَولٌ من لبنٍ: أي بَقيَّة. ويكون ذلك بَعد سَبعة أشهُر من حَمْلها، ومنه حديث عليّ (فَكَأَنَّكُمْ بِالسَّاعَةِ تَحْدُوكُمْ حَدْو الزَّاجِرِ بِشَوْلِهِ) أي الذي يزجُرُ إبلَه لتَسِير) (2) .
والتاء في (شولة) تأنيث أو مصدر، أي ذات شول.
و الشائلة: واحدة الشوائل.
(و شُوَّل كرُكَّع: جمع شائل، وهي الناقة الّتي تشول بذنبها للّقاح، ولا لبن لها أصلاً، وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر أو ثمانية. و شوّلت الناقة...: أي صارت شائلة. و شوّال أحد فصول السّنة... سمّى بذلك لشَوَلان الإبل بأذنابها في ذلك الوقت لشدّة شهوة الضّراب؛ ولذلك كرهت العرب التّزويج فيه، وعن النّبي (صلّى الله عليه وآله): (سمّي شوّالاً لأنّ فيه شالت ذنوب المؤمنين) أي ارتفعت وذهبت) (3) .
و الحَدْو : سوق الإبل.
و الحادي:
____________________
(1) النهج 9: 209، 158/ط.
(2) النهاية في (شول).
(3) مجمع البحرين في (شول) [نقل بتصرُّف].
السائق لها.
و الحدّي : التغنّي لجدّ السير.
وإنّما شبّه (عليه السّلام) اندفاع النّاس بالسّاعة - أي القيامة - بسائق الناقة، القليلة اللّبن أو عديمته، في سرعة سيرها؛ لخفّتها ولزجرها، أي أنّ السّاعة تقهركم على الموقف لمحاسبتكم على أعمالكم: إن خيراً فخير وإن شرّاً فشرّ. وكرّر منه (عليه السّلام) التّعبير بالحَدْو، ومنه: (وَرَاءَكُمُ السَّاعَةَ تَحْدُوكُمْ) (1) (وإِنَّ السَّاعَةَ تَحْدُوكُمْ)، بل ( بَلْ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ ) (2) من الزجر والقتل والأسر وأفظع من كلّ فظيع وأدهى من الدّواهي كلّها.
____________________
(1) النهج 1: 301، 21/ط.
(2) سورة القمر الآية 46.
الحاء مع السّين
11- الحَسَدُ يأكلُ الإيمان كَما يأكُل النّارُ الحَطَب (1) .
من التمثيلات صادرة عن الإمام (عليه السّلام) في إحدى خطبه، قال فيها: (وتَحَاسَدُوا فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الإيمَانَ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ).
من الإيمان أن يعقد المؤمن قلبه على أنّه تعالى يؤتي الملك من يشاء وينزعه عمّن يشاء، ويؤتي الفضل من رزق وغيره، كما قال تعالى: ( أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) (2) . فإذا تمنّى زوال ذلك وانفجر من وجوده فقد عارض إلهه في قضائه وعطائه، وهو مناف للإيمان بها، فكيف يبقى الإيمان؟! بلى يفنى كما تفني النّارُ الحطب.
ثم الحسد جاء الأمر بالتعوّذ من شرّه كما قال تعالى: ( وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ) (3) ، وفي النبويّ: (... وكاد الحسد أن يغلب القدر)، والصادقيّ: (آفة الدّين الحسد والعجب والفخر)، والنبويّ: (قال الله (عَزَّ وجَلَّ) لموسى بن عمران: يا ابن عمران، لا تحسدنّ النّاس على ما آتيهم من فضلي، ولا تمدّن عينيك إلى ذلك ولا تتبعه نفسك، فإنّ الحاسد ساخط لنعمي، صادّ لقسمي الذي قسّمت بين عبادي، ومن يك كذلك فلست منه وليس منّي) (4) . وهو من داعية الذنوب، قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): (... الحرص والكبر والحسد دواعٍ إلى التقحّم في الذنوب) (5) . وكما لا يسلم له إيمان لم تبق صحّة البدن معه، قال (عليه السّلام): (العجبُ لغفلة الحسّاد عن سلامة الأجساد) (6) ،
____________________
(1) النهج 6: 354، 85/ط.
(2) سورة النساء الآية 54.
(3) سورة الفلق الآية 5.
(4) أصول الكافي 2: 307.
(5) النهج 19: 301.
(6) النهج 19: 49.
وقال (عليه السّلام): (صحّة الجسد من قلّة الحسد) (1) . والحسد غلّ في عنق صاحبه وقد نفاه (عليه السّلام) عن الملائكة عند وصفهم: (ولا تَوَلاهُمْ غِلُّ التَّحَاسُدِ) (2) وأيّ فرق بين من على عنقه غلّ ظاهريّ ومن شغل قلبه وملك عقله الحسد؟! والجامع بينهما سلب الاستطاعة والراحة.
وكرّر هذا التمثيل المذكور في كلامه (عليه السّلام) في أكل الحسد الإيمان بأكل النّار الحطب في الأحاديث ومنها النبويّ (3) .
____________________
(1) المصدر 97.
(2) المصدر 6: 425.
(3) في (الأمثال النبويّة حرف الحاء).
الحاء مَعَ الكاف
12- الحكمةُ ضالةُ المؤُمنِ (1) .
قال (عليه السّلام):
(خُذِ الْحِكْمَةَ أَنَّى كَانَتْ، فَإِنَّ الْحِكْمَةَ تَكُونُ فِي صَدْرِ الْمُنَافِقِ فَتَلَجْلَجُ فِي صَدْرِهِ حَتَّى تَخْرُجَ فَتَسْكُنَ إِلَى صَاحِبِهَا فِي صَدْرِ الْمُؤْمِنِ). قال الرضي (رحمه الله): وقد قال عليّ (عليه السّلام) في مثل ذلك: (الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَخُذِ الْحِكْمَةَ ولَومِنْ أَهْلِ النِّفَاقِ).
قال الميداني: (يعني أنّ المؤمن يحرص على جمع الحكم من أين يجدها يأخذها) (2) .
يمكن أن لا يعلم أنّه لأمير المؤمنين (عليه السّلام)، أو كونه مثلاً نبويّاً، ولكن بعيد من مثله، ونحن عددناه من الأمثال النبويّة والعلويّة ولا تنافي ذلك. قيل: (خطب الحجّاج فقال: إنّ الله أمرنا بطلب الآخرة وكفانا مئونة الدنيا، فليتنا كفينا مئونة الآخرة وأمرنا بطلب الدنيا. فسمعها الحسن [ البصري ] فقال: هذه ضالّة المؤمن خرجت من قلب المنافق) (3) .
[ تعريف الحكمة: ]
عرفت الحكمة بتعاريف، فقيل: هي فهم المعاني، وطاعة الله ومعرفة الإمام، وإتقان الأمور. وأجمع تعريف: هي العلم بشرائع السماء والعمل بها. وقيل: العلم بمصالح الدارين ومفاسدهما. وقيل: النبوّة. وقيل غير ذلك.. ذكرنا نبذة من
____________________
(1) النهج 18: 229، 77/ح.
(2) المجمع 1: 214 حرف الحاء.
(3) شرح النهج 18: 229.
الأقوال في حرف الحاء من الأمثال النبويّة جاء في الحديث: (من أخلص لله أربعين صباحاً جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه) (1) .
[ عوامل حصول الحكمة: ]
من عوامل حصول الحكمة قلّة الكلام، ونوم القيلولة، وقلّة الأكل، ومجالسة الأتقياء، وصلاة الليل، وقراءة القرآن الكريم، وإخلاص العمل لله (عَزَّ وجَلَّ)، ومعرفة الله والنبيّ والأئمّة (صلّى الله عليهم أجمعين)، والطاعة له تعالى. وليست الحكمة المرضيّة هي المصطلحة عند قوم.
____________________
(1) السفينة 1: 408 في خلص.
الحاء مع النّون
13- حَنَّ قِدْحٌ لَيْس مِنْها (1) .
من أمثال سائرة تمثّل به أمير المؤمنين (عليه السّلام) في جواب كتاب معاوية (... وما لِلطُّلَقَاءِ وأَبْناءِ الطُّلَقاءِ! وَالتَّمْيِيزَ بَيْنَ الْمُهاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ، وتَرْتِيبَ دَرَجاتِهِمْ، وتَعْرِيفَ طَبَقاتِهِمْ؟! هَيْهاتَ! لَقَدْ حَنَّ قِدْحٌ لَيْسَ مِنْها، وطَفِقَ يَحْكُمُ فِيها مَنْ عَلَيْهِ الْحُكْمُ لَها).
(حنّ) من الحنين، وهو نوع صوت.
و(قِدْح: أصله من القداح، من عود واحد يجعل فيها قدح من غير ذلك الخشب فيصوّت إذا أرادها المفيض، فذلك الصوت هو حنينه. هذا مثل يضرب لمن يدخل نفسه بين قوم ليس له أن يدخل بينهم) (2) ، أو لمن يفتخر بقوم ليس منهم، أو يمتدح بما لا يوجد فيه.
قيل: المثل لعمر أجاب به عقبة بن أبي معيط حينما قال له: (أأقتل من بين قريش؟!).
قال الزمخشري: وقيل: بني الحنان، وهم بطن من بلحارث، أنّ جدّهم ألقى قِدْحاً في قداح قوم يضربون بالميسر وكان يضرب لهم رجل أعمى، فلما وقع قِدْحه في يده قال: (حنّ قِدْح ليس منها) فلقب الحنان لذلك.
ومنه يظهر: أنّ المثل ليس لعمر، ويؤيّد ذلك قول الميداني إنّ عمر تمثّل به (3) .
والقِدْح السهم من أقداح الميسر، وعند إجالتها خالف
____________________
(1) النهج 15: 181، 28/ك.
(2) شرح النهج 15: 191 [العبارة لابن أبي الحديد والمؤلف تصرَّف في تقديم بعضها على بعض].
(3) رسالة الإسلام 117 - 118 العدد 7- 8.
صوت القِدح الذي ليس من مادّة بقية القداح صوتها، فيعرف أنّه ليس من جملتها.
قيل: إنّ كلام الإمام (عليه السّلام) تصديق للشيخين لأنّهما من المهاجرين ذوي الرتب والدرجات التي لم يكن لمعاوية صلوح التمييز لها، بل لابدّ من مثل الإمام (عليه السّلام) يميّزها لأنهما في درجته في الفضل.
والجواب: أنّ الكلام جاء كمقياس كليّ لا ينطق إلاّ على موارده الحقيقية بدون تعيين.
باب الدال
الدّال مَعَ العين
14- دَعْ عَنْكَ مَنْ مالَتْ بِهِ الرَّمْيَّةُ (1) .
من كلام له (عليه السّلام) في جواب لكتاب معاوية الذي يذكر فيه بعض الناس، قال (عليه السّلام): (... فَدَعْ عَنْكَ مَنْ مَالَتْ بِهِ الرَّمِيَّةُ فَإِنَّا صَنَائِعُ رَبِّنَا والنَّاسُ بَعْدُ صَنَائِعُ لَنَا...).
الرَّمْيَّةُ بمعنى الرمي، والباء للإلصاق: أي دع من رمته الدنيا بسهامها وصار غرضاً لها لإقباله عليها. ويشهد لذلك ما جاء في بعض خطبه (عليه السّلام) (تَرْمِيهِمْ بِسِهامِها، وتُفْنِيهِمْ بِحِمامِها) (2) .
ويصحّ ذلك أيضاً رميه بسهام النفس وإبليس، إذ استعارة رمي السهام فيها بجامع التأثير السريع على حدّ سواء، وقد جاء (النظرة سهم مسموم من سهام الشيطان) (3) .
وقيل الرَّمْيَّةُ: الطريدة المرميّة. (يقال للصيد: يرمي هذه الرَّمْيَّة، وهي (فَعْليَّة) بمعنى مفعولة، والأصل في مثلها أن لا تلحقها الهاء نحو: (كفّ خضيب، وعين كحيل) إلاّ أنّهم أجروها مجرى الأسماء لا النعوت كالقصيدة والقطيعة، والمعنى: دع ذكر من مال إلى الدنيا ومالت به، أي أمالته إليها) (4) .
____________________
(1) النهج 15: 182، 28/ك.
(2) النهج 11: 257، 221/ط.
(3) الوسائل 14: 138 - 140.
(4) شرح النهج 15: 194.
عن الشيخ محمد عبده: (يضرب لمن أعوّج غرضه فمال عن الاستقامة لطلبه) (1) .
قيل: المراد من الموصول في المثل هو عثمان لا الشيخان؛ لأنّه (عليه السّلام) لم يذكرهما بقدح والمثل يضرب لذلك، فلابدّ من صرفه إلى غيرهما (2) .
يجاب عنه: أنّ الكلام مقياس كليّ له اطّراده في جميع الناس إذا تحقّقت فيه الرّمية مهما كان نوعه، ومعاوية المخاطب من أجلى مصاديقه، ومن تدبّر صدر الكلام عرف الحق.
____________________
(1) رسالة الإسلام 118 - عدد 7 - 208.
(2) شرح النهج 15: 194.
الدّال مَعَ الهاء
15- الدَّهرُ يَومَانِ: يَوْمٌ لكَ وَيَوْمٌ عَليْك َ (1) .
من كلام الإمام (عليه السّلام) الجاري مجرى الأمثال: (الدَّهْرُ يَوْمَانِ: يَوْمٌ لَكَ، ويَوْمٌ عَلَيْكَ. فَإِذَا كَانَ لَكَ فَلاَ تَبْطَرْ، وإِذَا كَانَ عَلَيْكَ فَاصْبِرْ).
قال الشارح:
(قديماً قيل هذا المعنى: الدّهر يومان: يوم بلاء ويوم رخاء، والدّهر: ضربان: حبرة وعبرة، والدّهر وقتان: وقت سرور ووقت ثبور. وقال أبو سفيان يوم أحد: يوم بيوم بدر، والدّنيا دول. ويحمل ذمّ البطر هاهنا على محملين: أحدهما البطر بمعنى الأشر وشدّة المرح. بَطِر الرجل (بالكسر) يبطر وقد أبطره المال، وقالوا: بطر فلان معيشته، كما قالوا: رشد فلان أمره. و الثاني البطر بمعنى الحيرة والدّهش، أي إذا كان الوقت لك فلا تقطعنّ زمانك بالحيرة والدّهش عن شكر الله، ومكافأة النعمة بالطّاعة والعبادة، والمحمل الأوّل أوضح) (2) .
الدّهر هو ما سوى الله جلّ جلاله برمّته، الممتدّ من البداية إلى النهاية. وربّما يتخيّل أنّه المنتزع من الحدّين، وواقع المنتزع - كمّا تقدّم - هو المجزوم، ولامتداده ظنّ قِدَمه حتّى زعم الدّهريّون أنّه منشأ الحياة والهلاك كما حكى عنهم الله (جلّ جلاله): ( وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ ) (3) . فإن أرادوا به الله تعالى وجهلوا أنّه هو، أو أجروا عليه تعالى اسم الدّهر، فهذا أهون
____________________
(1) النهج 19: 364، 406/ح.
(2) المصدر.
(3) سورة الجاثية الآية 24.
من الأوّل.. والبحث في محلّه.
يريد (عليه السّلام) أنّ للدّنيا إقبالاً وإدباراً، فإن أقبلت عليك فلا تغترّ بها فتنسى كلّ شيء، وإن أدبرت فاصبر. وقد جاء في الحديث القدسي: (يا موسى، إن أقبلت الدّنيا فعقوبة عُجّلت، وإن أدبرت فقل مرحباً بشعار الصّالحين) (1) .
____________________
(1) مجموعة ورّام 2: 43.
باب الراء
الرّاء مَعَ الباء
16 - رُبَّ قولٍ أَنْفَذُ من صَوْلٍ (1) .
وهذا المثل ذكره جمع، منهم: المفضّل (2) . والميداني بعد إيراده بلفظ (ربّ قول أشدّ من صول) ، وكذا الزمخشري (3) ، قال: (يضرب عند الكلام يؤثِّر فيمَن يواجَه به، قال أبو عبيد: وقد يضرب هذا المثل فيما يتّقي من العار. وقال أبو الهيثم: (أشدّ) في موضع خفضٍ؛ لأنّه تابع للقول. وما جاء بعد (ربّ) فالنّعت تابع له) (4) .
قال الشارح:
(قد قيل هذا المعنى كثيراً (والقول ينفذ ما لا تنفذ الإبر)، ومن ذلك: (القول لا تملكه إذا نما، كالسّهم لا تملكه إذا رمى)، وقال الشاعر:
وَقافِيَةٍ مِثلِ حَدِّ السِنا |
نِ تَبقى وَيَذهَبُ مَن قالَها |
|
تَخَيَّرْتُها ثُمَّ أرْسَلْتُهَا |
ولَمْ يُطِقِ النّاسُ إرْسَالَها |
وقال محمود الورّاق:
أَتاني عَنكَ ما لَيسَ |
عَلى مَكروهِهِ صَبرُ |
|
فَأَغضَيتُ عَلى عَمدٍ |
وَكَمْ يُغضي الفَتى الحُرُّ |
|
وَأَدَّبتُكَ بِالهَجرِ |
فَما أَدَّبَكَ الهَجرُ |
|
وَلا رَدَّكَ عَمّا كا |
نَ مِنكَ الصَفحُ وَالبِرُّ |
|
فَلَمّا اِضطَرَّني المَكرو |
هُ وَاِشتَدَّ بِيَ الأَمرُ |
|
تَناوَلتُكَ مِن شِعرّي |
بِما لَيسَ بِهِ قَدرُ |
|
فَحَرَّكتَ جَناحَ الضُرِّ |
لَمّا مَسَّكَ الضُرُّ) |
____________________
(1) النهج 19: 359، 402/ح.
(2) الفاخر 265.
(3) المستقصي 2: 98.
(4) مجمع الأمثال 1: 290 حرف الراء.
(5) النهج 19: 359.
17 - رُبَّ مَلُومٍ لا ذَنْبَ لَهُ (1) .
في جواب لكتاب معاوية: (وما كُنْتُ لِأََعْتَذِرَ مِنْ أنِّي كُنْتُ أَنْقِمُ عَلَيْهِ أحْداثاً، فَإِنْ كانَ الذَّنْبُ إِلَيْهِ إِرْشادِي وهِدايَتِي لَهُ، فَـ "رُبَّ مَلُومٍ لا ذَنْبَ لَهُ ". وقَدْ يَسْتَفِيدُ الظِّنَّةَ الْمُتَنَصِّحُ وما أَرَدْتُ إِلا الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ، وما تَوْفِيقِي إِلاّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وإِلَيْهِ أُنِيبُ).
هذا جزء من كلام له (عليه السّلام) بهذا الصدد حيث اتّهم معاوية الإمام (عليه السّلام) بالاشتراك في قتل عثمان فأجاب عنه: بأني كنت ناقماً عليه لأحداث ارتكبها. وليست هذه النقمة شركة في قتل عثمان، بل كانت هداية له وإرشاداً، فإن كنت - يا معاوية - تلومني على ذلك (فربّ ملومٍ لا ذنب له) وما أنا ذا ملوم، بلا ذنب ركبته.
قال الزمخشري: (ربَّ ملومٍ لا ذنب له: قاله الأحنف لرجل ذمّ عنده الكمأة مع السمن، قال (بحر المتقارب):
فلا تلمْ المرءَ في شأنِه |
فربَّ ملومٍ ولم يُذْنِبِ) (2) |
و(رُبَّ لاَئِمٍ مُلِيْمٌ) (3) وهو معاوية وأضرابه من قالة الباطل.
قيل: (قائل: (ربّ ملوم لا ذنب له) هو أكثم بن صيفي، يقول قد ظهر للناس منه أمر أنكروه عليه وهم لا يعرفون حجّته وعذره، فهو يلام عليه. وذكروا أنّ رجلاً في مجلس الأحنف بن قيس قال: ليس شيء أبغض إليّ من التمر والزبد، فقال الأحنف: ربّ ملوم لا ذنب له) (4) .
تقدّم انتماء
____________________
(1) النهج 15: 183، 28/ك.
(2) المستقصي 2: 99.
(3) المصدر 2: 98.
(4) مجمع الأمثال 1: 305 حرف الراء [بتصرف طفيف].
المثل إلى الأحنف من صاحب المستقصي. ثم الملامة أشدّ مراتب العتاب، وهي تخطيء وتصيب.
الرّاء مَعَ الدّال
18- رُدُّوا الحَجَرَ مِنْ حَيْثُ جَاء َ (1) .
قال (عليه السّلام): (رُدُّوا الْحَجَرَ مِنْ حَيْثُ جَاءَ فَإِنَّ الشَّرَّ لا يَدْفَعُهُ إِلاَّ الشَّرُّ).
قال الشارح:
(هذا مثل قولُهم في المثل : إنّ الحديد بالحديد يفلح (2) . وقال عمرو بن كلثوم:
أَلا لا يَجهَلَنْ أَحَدٌ عَلَينا |
فَنَجهَلَ فَوقَ جَهلِ الجاهِلينا |
وقال الفند الزّماني:
فَلَمّا صَرَّحَ الشَرُّ |
فأمسى وهو عُريانُ |
|
وَلَم يَبقَ سِوى العُدوا |
نِ دِنّاهُم كَما دانوا |
|
وَبَعضُ الحِلمِ عِندَ الجَهـ |
لِ لِلذِلَّةِ إِذعانُ |
|
وفي الشَّرِّ نجاةٌ حيـ |
نَ لا يُنجِيكَ إحسانُ |
وقال الأحنف:
وذي ضَغَنٍ أمتُّ القَوْلَ عنه |
بحِلْمِي فاسْتَمَرَّ على المَقَالِ |
|
وَمَن يَحلُم وَلَيسَ لَهُ سَفِيهٌ |
يُلاقِ المُعْضِلاتِ مِنَ الرِجالِ) (3) |
من أمثال متناسبة: (الشرّ بالشرّ ملحق) (4) ، (الشرّ للشرّ خلق) (5) .
____________________
(1) النهج 19: 221، 320/ح.
(2) مجمع الأمثال 1: 11 حرف الهمزة.
(3) شرح النهج 19: 221.
(4) النهج 18: 41.
(5) مجمع الأمثال 1: 366 حرف السين.
وقد جاء في صادقيّ: (إن اللعنة إذا خرجت من فيِّ صاحبها تردَّدت فإن وجدت مساغاً وإلاّ رجعت على صاحبها) (1) .
والغرض من ردّ الحجر منع تجاوز الظالم الغاشم بردّ ظلمه إليه، فإنّ الظلم شرّ وشر منه صاحبه كالظالم كما تقدّم المثل (2) . فإذا لم يردّ على المتجاوز تجاوزه ازداد تجاوزاً، وإذا عومل بمثل ما صنع ارتدع. فصبر المظلوم زيادة في ظلم الظالم، ولا ينافيه ما جاء في الصّبر؛ فإن ذلك فيما لم يكن الردّ عليه.
وحمْلُ الحجر على معناه الظاهري لا يمنع من معناه المثلي، أي من ردّ ظلم الظالم إليه.
____________________
(1) السفينة 1: 512 في (لعن).
(2) فاعل الخير خير منه، وفاعل الشرّ شرّ منه.
الرّاء مَعَ الفاء
19- الرَّفيقُ قَبلَ الطَّريقِ، وَالجارُ قَبلَ الدّار ِ (1) .
من وصيّته للحسن (عليهما السّلام) المطوّلة، قال فيها: (سَلْ عَنِ الرَّفِيقِ قَبْلَ الطَّرِيقِ، وعَنِ الْجَارِ قَبْلَ الدَّارِ).
وفي المثل: (الرفيق إمّا رحيق أو حريق)، وفي المثل: (جار السوء كلب هارش وأفعى ناهش) (2) .
قوله (عليه السّلام): (الرَّفِيقِ قَبْلَ الطَّرِيقِ) من الأمثال، ذكره بعض الأدباء، منهم الميداني، قال بعد ذكر المثل: (أي حَصِّلِ الرفيق أولاً واخْبُرْهُ، فربَّما لم يكن موافقاً ولم تتمكّن من الاستبدال به) (3) . و[ قال: الميداني ] بعد مثل (الجار ثم الدار) بذكر (ثمّ)، قال: (هذا كقولهم: (الرفيق قبل الطريق) وكلاهما يروي عن النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم). قال أبو عبيد: كان بعض فقهاء أهل الشام يحدّث بهذا الحديث ويقول: معناه إذا أردت شراء دار فسَلْ عن جوارها قبل شرائها) (4) .
ثم الجار نذكر شيئاً من حقوقه لأدنى مناسبة:
اهتمّ الشرع الإسلامي بالجار حتّى قال الإمام (عليه السّلام) في وصيّة له: (واللَّهَ اللَّهَ فِي جِيرَانِكُمْ فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ) (5) ، وقال تعالى: ( وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ... ) (6) .
____________________
(1) النهج 16: 113، 31/الوصيّة.
(2) شرح النهج 16: 121.
(3) المجمع 1: 303 حرف الراء.
(4) المجمع 1: 172 (حرف الجيم).
(5) النهج 17: 5، 47/الوصيّة.
(6) سورة النساء الآية 36.
الجار إمّا قريب أو بعيد، وهما إمّا قريب أو أجنبيّ، فهذه أربعة: فالجار ذو الرحم، قريباً كان أو بعيداً، داخل في ( وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى ) . والأجنبي، القريب والبعيد، في ( وَالْجَارِ الْجُنُبِ ) . ( وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ ) هو الذي يصحبك في السفر جنباً إلى جنب.
ثم ليس حسن الجوار كفّ الأذى عنه فقط، بل بتحمّل الأذى والصبر على ما يرى، قال القائل:
ليس حسن الجوار كفّ الأذى |
ولكن حسن الجوار الصبر (1) |
____________________
(1) ذكرناه في الأمثال النبويّة حرف الجيم.
الرّاء مَعَ الكاف
20- رَكِبْنا أعْجازَ الإِبِل وإِنْ طَالَ السُّرى (1) .
والأصل فيه قوله (عليه السّلام): (لَنَا حَقٌّ فَإِنْ أُعْطِينَاهُ وإِلا رَكِبْنَا أَعْجَازَ الإبِلِ وإِنْ طَالَ السُّرَى).
قال الرضي (رحمه الله تعالى): (وهذا القول من لطيف الكلام وفصيحه، ومعناه: أنّا إن لم نعط حقّنا كنّا أذلاّء؛ وذلك أن الرديف يركب عجز البعير، كالعبد والأسير ومن يجري مجراهما).
قال بعض الشرَّاح:
(له تفسيران: أحدهما : أنّ راكب عجز البعير يلحقه مشقّة وضرر، فأراد: أنّا إذا منعنا حقّنا صبرنا على المشقّة والمضرّة كما يصبر راكب عجز البعير. وهذا التفسير قريب مما فسّره الرّضي، و الوجه الثاني: أنّ راكب عجز البعير إنّما يكون إذا كان غيره قد ركب على ظهر البعير، وراكب ظهر البعير متقدّم على راكب عجز البعير، فأراد: أنّا إذا منعنا حقّنا تأخّرنا وتقدّم غيرنا علينا فكنّا كالراكب رديفاً لغيره. وأكّد المعنى على كلا التفسيرين بقوله: (وإِنْ طَالَ السُّرَى)؛ لأنّه إذا طال السُّرى كانت المشقّة على راكب البعير أعظم، وكان الصبر على تأخّر راكب عجز البعير عن الراكب على ظهره أشدّ وأصعب.. قاله يوم الشُّورى) (2) .
وقال آخر:
(عليّ (رضي الله تعالى عنه) قال يوم الشورى: (لنا حقّ إن نعطه نأخذه، وإن نمنعه نركب أعجاز الإبل وإن طال السُّرى). هذا مثل لركوبه الذلّ والمشقّة وصبره عليه وإن تطاول ذلك، وأصله أن الراكب إذا اِعْرَوْرى
____________________
(1) النهج 18: 132، 22/ح.
(2) المصدر.
البعير ركب عجزه من أصل السنام، فلا يطمئنّ ويحتمل المشقّة. وأراد بركوب أعجاز الإبل كونه ردفاً تابعاً، وأنّه يصبر على ذلك وإن تطاول به. ويجوز أن يريد: وإن نمنعه نبذلِ الجهد في طلبه فعل من يضرب في ابتغاء طلبته أكباد الإبل ولا يبالي باحتمال طول السُّرى) (1) .
وهكذا غيرهما من الجمهور، قد خصّصوا كلامه (عليه السّلام) بيوم الشُّورى بعد وفاة عمر واجتماع الجماعة لاختيار واحد من الستّة. وليت شعري لِمَ خصّصوه بذلك؟! وهل كان منْع القوم الإمام (عليه السّلام) عن حق الخلافة من بعد عمر وكان له ولصاحبه الحق وليس له (عليه السّلام) منه نصيب؟! أو خصّصهما الله ورسوله به دونه [ ما ] أو أنّه خاصّ به تقّمصه القوم؟! اختر ما شئت!
____________________
(1) الفائق [ في غريب الحديث، جار الله الزمخشري] 2: 397 - 398.
باب السين
السّين مَعَ الرّاء
21- سُرُوحُ عَاهَةٍ بِوَادٍ وَعْثٍ (1) .
أحد الأمثال الّتي ضربها في وصيّته لابنه الحسن (عليهما السّلام)، قال فيها:
(وإِيَّاكَ أَنْ تَغْتَرَّ بِمَا تَرَى مِنْ إِخْلادِ أَهْلِ الدُّنْيَا إِلَيْهَا، وتَكَالُبِهِمْ عَلَيْهَا؛ فَقَدْ نَبَّأَكَ اللَّهُ عَنْهَا ونَعَتَتْ نَفْسِهَا وتَكَشَّفَتْ لَكَ عَنْ مَسَاوئهَا. فَإِنَّمَا أَهْلُهَا كِلابٌ عَاوِيَةٌ وسِبَاعٌ ضَارِيَةٌ يَهِرُّ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، ويَأْكُلُ عَزِيزُهَا ذَلِيلَهَا، ويَقْهَرُ كَبِيرُهَا صَغِيرَهَا. نَعَمٌ مُعَقَّلَةٌ وأُخْرَى مُهْمَلَةٌ، قَدْ أَضَلَّتْ عُقُولَهَا ورَكِبَتْ مَجْهُولَهَا " سُرُوحُ عَاهَةٍ بِوَادٍ وَعْثٍ "، لَيْسَ لَهَا رَاعٍ يُقِيمُهَا ولا مُسِيمٌ يُسِيمُهَا...).
وهي وصيّة مطوّلة أخذنا منها ما يربط المثل الجاري.
قال الشارح:
(ثلاثة أمثال محرّكة لمن عنده استعداد، واستقرأني أبو أفرج محمد بن عبّاد (رحمه الله) وأنا يومئذٍ حَدَثٌ هذه الوصيّة، فقرأتها عليه من حفظي، فلمّا وصلت إلى هذا الموضع صاح صيحة شديدة وسقط، وكان جباراً قاسي القلب.
(سُرُوحُ عَاهَةٍ) والسروح: جمع سرح، وهو المال السارح. والعاهة: الآفة.... ووادٍ وعثٍ لا يثبت الحافر والخفّ فيه، بل يغيب فيه ويشقّ على من يمشي فيه) (2) .
أو السروح: الأغنام.
يقول (عليه السّلام) أهل الدّنيا كلاب
____________________
(1) النهج 16: 89 - 90، 31/الوصية.
(2) شرح النهج 16: 90 - 91.
عاوية وسباع جائعة يتناهشن على جيف أو أغنام سائمة ترعى، ومعقّلة متحيّرة في أودية لا يثبت فيها خفّ ولا خافر. لا راعي يرعاها، وقد اعتورها الآفات من كلّ جوانبها.
برزت في كلامه (عليه السّلام) حقائق أهل الدّنيا وبوائق ما طالت الأيّام تخفينها، وسوف يحشر الناس على ما هم فيه من صفات الحيوانات كما جاء في تفسير ( وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ) (1) يأتون يوم القيامة على صور ما كانوا يزاولون من صفات الكلاب والسّباع وغيرها.
____________________
(1) سورة التكوير الآية 5.
باب الشين
الشّين مَعَ التّاء
22 -
شَتَّانَ مَا يَومي على كُورِها |
|
وَيَومَ حَيّانَ أَخي جَابِر (1) |
تمثّل (عليه السّلام) بالبيت في خطبته المعروفة بـ (الشِقْشِقِّية). قال المعتزلي إنّ البيت للأعشى الكبير أعشى قيس، وهو أبو بصير ميمون بن قيس بن جندل من القصيدة التي قالها في منافرة علقمة بن علاثة وعامر بن الطفيل (2) ، وأوّلها:
شاقَتْكَ مِنْ قَتْلَة أَطْلالُها |
بالشَّطِّ فَالوِتْرِ إِلى حاجِرِ |
|
فَرُكنِ مِهراسٍ إِلى مارِدِ |
فَقاعِ مَنفوحَةَ ذي الحائِرِ |
|
دارٌ لَها غَيَّرَ آياتِها |
كُلُّ مُلِثٍّ صَوبُهُ زاخِرِ |
والضمير في كورها في البيت المتمثّل به يعود على الناقة في بيت متقدّم عليه:
وَقَد أُسَلّي الهَمَّ حينَ اِعتَرى |
بِجَسرَةٍ دَوسَرَةٍ عاقِرِ |
|
وقد أسلى المهمّ حين اعترى |
بجسرة (3) دوسرة عاقر |
|
زَيّافَةٍ بِالرَحلِ خَطّارَةٍ |
تُلْوي بِشَرخَي مَيسَةٍ قاتِرِ |
وحيّان اسم رجل من بني حنيفة كان سيّداً مطاعاً وذا نعمة وافرة وكان الأعشى ينادمه. وجابر: أخو حيّان أصغر منه ذكره الشاعر للقافية. ومعنى البيت: فرق كبير ما بين سفري على ناقتي وبين يوم حيّان في نعمته الوافرة.
____________________
(1) النهج 1: 162، 3/ط.
(2) شرح النهج 1: 166.
(3) الجسرة العظيمة من الإبل والدوسرة الناقة الضخيمة.
يشير (عليه السّلام) به إلى أنّ هناك فرقاً بين يومه في الخلافة مع ما انتقض عليه من الأمر مع يوم عمر حيث ولّها على قاعدة ممهّدة (1) .
وحصيلة ذلك: أنّ الفرق بين راكب الناقة الراقلة به وحيّان المتنعّم بنعمة ناعمة وراحة هو الفرق بيني في خلافتي الّتي انتقض أمرها وبين عمر الذي مهّدت له الأمور كما أراد وأرادها الأوّل، وهذا من دلالات مظلوميّته (عليه السّلام) واغتصاب حقه الثابت؛ فلو كان الأمر على ضوء وصاية النبيّ (صلّى الله عليه وآله) سائراً لما اغتصب حقّ الخلافة منه ولا حقّ إلى يوم القيامة.
____________________
(1) رسالة الإسلام 120 - 121 (عدد 7 - 8).
الشّين مَعَ الرّاء
23 - الشَّرُّ بِالشَّرِّ مُلْحَقٌ (1) .
قاله (عليه السّلام) في كتاب له كتبه إلى الحارث الهمداني:
(... وإِيَّاكَ ومُصَاحَبَةَ الْفُسَّاقِ فَإِنَّ الشَّرَّ بِالشَّرِّ مُلْحَقٌ...).
قال الشارح:
يقول: (إنّ الطّباع ينزع بعضها إلى بعض فلا تصحبنّ الفسّاق فإنّه ينزع بك ما فيك من طبع الشر إلى مساعدتهم على الفسوق والمعصية وما هو إلاّ كالنّار فإذا لم تجاورها وتمازجها نار كانت إلى الانطفاء والخمود أقرب. وروى (ملحِق) (بكسر الحاء) وقد جاء في الخبر النبويّ: (عذابك بالكفار ملحِق) بالكسر) (2) .
قوله (عليه السّلام): (الشرّ بالشرّ ملحق).
معدود من الأمثال، نظير قولهم: (الشرّ للشرّ خلق) و(الحديد بالحديد يفلح) (3) . والإنسان المغفّل إذا صاحب الفاسق أثّر فسقه فيه وزاد هو في فسقه، وإن لم يكن على حذر منه فلا محالة جاء التأثير وزيادة الفسق بزيادة أفراد الفسّاق، وهو المصاحب، إذ المصاحبة مؤثّرة إن خيراً فخير وإن شرّاً فشرّ. وجاء في حديث الإمام السّجاد (عليه السّلام) النهي عن مصاحبة خمسة ومحادثتهم ومرافقتهم في طريق، وهم: الكذّاب والفاسق والبخيل والأحمق والقاطع لرحمه (4) .
____________________
(1) النهج 18: 41، 69/ك.
(2) شرح النهج 18: 50 - 51.
(3) السفينة 2: 8 في (صحب).
ونسب إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام) ما يلي:
(عاشرْ أخا ثقةٍ تحظى بصحبته |
فالمرءُ مكتسِبٌ من كلّ مصحوبِ |
|
كالرّيح آخذةٌ حين تمرّ به |
نَتْنٌ من النتنِ والطيْبُ من الطيبِ) (1) |
ومن آثار سوء مصاحبة الفاسق أنّه مظنّة سخط الله (عزّ وجلّ)، وعذابه إذا نزل عمّ من معه. كما كان عكس ذلك مصاحبة المتّقي الذي هو عرضة رحمة الله تعالى، فإنّها إن نزلت عمّت. والفسق هو الخروج عن طاعة الله تعالى الذي هو منشأ الشرور؛ إذ لا يأمن معه من ركوب المعاصي كلّها من الاجتماعيّة وغيرها الّتي تجب الشّرور.
____________________
(1) الديوان المنسوب إليه (عليه السّلام).
الشّين مَعَ القاف
24- شِقْشِقَةٌ هَدَرَتْ ثُمَّ قَرَّتْ (1) .
مثل سائر أجاب به الإمام (عليه السّلام) ابن عبّاس عندما سأله استرساله في كلام له من خطبة معروفة بالشقشقيّة لاشتمالها على الشقشقة، وقد ناوله رجل من أهل العراق كتاباً لينظر فيه فقطع (عليه السّلام) الخطبة ولم يعد إليها، فتأسّف ابن عباس عمّا فاته من إكمالها؛ لأنّها تبيّن مواقف الخلفاء الثلاثة مع الإمام (عليه السّلام) والخلال التي لا تليق بمنصب الخلافة. ومن العجيب من ابن أبي الحديد وغيره حيث أوّلوا الكلمات فيها إلى ما لا تنطبق عليه اللغة العربيّة، ومن له أدنى إلمام بها لم يرتب في مراد الإمام (عليه السّلام).
قال النيسابوري: (الشِقشِقة: شيء كالرئة يخرجها البعير من فيه إذا هاج. وإذا قالوا للخطيب: (ذو شقشقة) فإنّما يشبّه بالفحل) (2) .
وبعضُ مؤلفي كتب الأمثال لم يذكر المثل في كتابه ولا تمثّل الإمام (عليه السّلام) به لئلاّ يواجه مشكلة التأويل لكلامه (عليه السّلام)، وآخرٌ قد ذكر التمثّل به دون أن يزيد عليه، وثالثٌ نفي الخطبة عن أن تكون صادرة عن الإمام (عليه السّلام) فضلاً عن تمثّله به. والمعتزلي ممّن يقول بالصدور ويتصدّى للتأويل، قال:
إن قيل: بيّنوا لنا ما عندكم في هذا الكلام، أليس صريحه دالاًّ على
____________________
(1) النهج 1: 203 ط 3.
(2) مجمع الأمثال 1: 369 حرف الشين.
تظليم القوم ونسبتهم إلى اغتصاب الأمر، فما قولكم في ذلك؟ إن حكمتم عليهم بذلك فقد طعنتم فيهم، وإن لم تحكموا عليهم بذلك فقد طعنتم في المتظلّم المتكلّم عليهم؟
قيل: أمّا الإماميّة من الشيعة فتجري هذه الألفاظ على ظواهرها، وتذهب إلى أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) نصّ على أمير المؤمنين (عليه السّلام) وأنّه غصب حقّه.
وأمّا أصحابنا (رحمهم الله)، فلهم أن يقولوا:... (1) .
فراح يلّقنهم ما يلّفقونه لصرف الظهور.. والحديث ذو شجون.
____________________
(1) شرح النهج 1: 156 - 159.
باب الصاد
الصّاد مَعَ الألف
25 - صَاحِبُ السُّلطانِ كَراكِبِ الأَسَد ِ (1) .
من تمثيلات الإمام (عليه السّلام): (صَاحِبُ السُّلْطَانِ كَرَاكِبِ الأسَدِ يُغْبَطُ بِمَوْقِعِهِ وهُوأَعْلَمُ بِمَوْضِعِهِ).
قال بعض الشّراح:
(قد جاء في صحبة السلطان أمثال حكميّة مستحسنة تناسب هذا المعنى أو تجري مجراه، نحو قولهم: (صاحب السلطان كراكب الأسد يهابه الناس وهو لمركوبه أهيب) [...] (إذا صحبت السلطان فليكن مداراتك له مداراة المرأة القبيحة لبعلها المبغض لها، فإنّها لا تدع التصنّع له على حال) [...] (العاقل من طلب السلامة من عمل السلطان)؛ لأنّه إن عفّ حنى عليه العفاف عداوة الخاصّة، وإن بسط يده جنى عليه البسط ألسنة العامّة... ) (2) .
جاء التحذير البالغ في أحاديثهم (عليهم السّلام) من الدخول إلى دواوين الظلمة والسلاطين وإعانتهم ولو بقطّ قلم. ففي النبويّ: (إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: أين أعوان الظلمة ومن لاق لهم دواتاً أو ربط كيساً أو مّدّ لهم قلماً فاحشروهم معهم) (3) إذ لا يُأمن معهم من المعاصي وقتل النفس المحترمة واغتصاب أموال الناس، بل وترك جميع ما أوجبه الله (عزّ وجلّ) وركوب ما نهاه. ولا فرق بين العامل بالظلم والمعين والراضي به كما في الحديث (4) . نعم إذا
____________________
(1) النهج 19: 149، 269/ح.
(2) شرح النهج 19: 149 - 150.
(3) الوسائل 12: 130.
(4) الوسائل 11: 345.
قصد قضاء حوائج المؤمنين ونجاتهم من المهلكة، جاز. إلاّ أن يغلب عليه فلا يستطيع دفعاً عن نفسه، فضلاً عن غيره من النفوس. وعلي بن يقطين من النوع الجائز.
ثمّ الإمام (عليه السّلام) أراد من التمثيل براكب الأسد خطورة الأمر، حيث لا يأمن راكبه من الهلاك؛ ولعلّه يعمّ كلّ متسلّط لم يقيّده الإيمان ومقتدر وإن لم يكن بسلطان.
باب الضاد
الضّاد مَعَ الحاء
26- ضَحِّ رُوَيْداً (1) .
من الأمثال السائرة يستعمل للرفق وترك العجلة، جاء في كلام له (عليه السّلام) لابن عبّاس: (... وأُقْسِمُ بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَا أَخَذْتَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَلالٌ لِي أَتْرُكُهُ مِيرَاثاً لِمَنْ بَعْدِي، فَضَحِّ رُوَيْداً فَكَأَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ الْمَدَى ودُفِنْتَ تَحْتَ الثَّرَى، وعُرِضَتْ عَلَيْكَ أَعْمَالُكَ بِالْمَحَلِّ الَّذِي يُنَادِي الظَّالِمُ فِيهِ بِالْحَسْرَةِ...).
قال الشارح: (فضّح رويداً: كلمة تقال لمن يؤمر بالتؤدة والأناة والسكون، وأصلها الرجل يطعم إبله ضحى، ويسيّرها مسرعاً ليسير، فلا يشبعها، فيقال له: ضحّ رويداً) (2) .
قال الزمخشري: (ضحّ رويداً: أي ترّفق ولا تعجل وأصله أنّ الأعراب في باديتها تسير بالظعن فإذا عثرت على لمح من العشب قالت ذلك وغرضها أن يرعى الإبل قليلاً قليلاً وهي سائرة حتى إذا بلغت مقصدها شبعت فلمّا كان من الترّفق في هذا توسّعوا فقالوا: في كلّ موضع (ضّح) بمعنى ارفق والأصل ذاك قال زيد الخيل:
فَلَو أَنَّ نَصراً أَصلَحَت ذاتَ بَينِها |
لَضَحَّت رُوَيداً عَن مَطالِبِها عَمرُو) (3) |
وغرض الإمام (عليه السّلام) من الأمر بالترّفق أن ينبّه ابن عبّاس مغّبة
____________________
(1) النهج 16: 168، 41/ك.
(2) شرح النهج 16: 169.
(3) المستقصي 2: 145. أي يا عمرو.
الخيانة، ولابّد من الدخول في القبر والحشر والعرض على الله بالأعمال يوم ينادي الظالم بالحسرة ويعضّ على يديه وينادي بالويل والثبور، والأمر أفضح من ذلك ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه ) (1) .
____________________
(1) سورة الزلزلة الآية 7 - 8.
باب العين
العين مَعَ النّون
27- عِنْدَ الصَّباحِ يَحْمَدُ القَوْمُ السُّرى (1) .
من خطبة آخرها: (واللَّهِ لَقَدْ رَقَّعْتُ مِدْرَعَتِي هَذِهِ حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَاقِعِهَا. ولَقَدْ قَالَ لِي قَائِلٌ: أَلا تَنْبِذُهَا عَنْكَ؟! فَقُلْتُ: اغْرُبْ عَنِّي فَعِنْدَ الصَّبَاحِ يَحْمَدُ الْقَوْمُ السُّرَى).
قال المفضل: (أول من قال ذلك خالد بن الوليد...:
للّه دَرُّ رَافِع أَنَّي اهْتَدَى |
فَوّزَ من قُرَاقِر إلى سُوَى |
|
عِنْدَ الصَّبَاحِ يَحْمَدُ القَوْمُ السُّرَى |
وَتَنْجَلِي عَنهُمُ غَيَابَاتُ الْكَرَى) (2) |
قال الزمخشري: (أي إذا أصبح الذين قاسوا كدّ السّرى وقد خلّفوا تبجحوا بذلك وحمدوا ما فعلوا، يضرب في الحّث على مزاولة الأمر بالصبر وتوطين النفس حتّى تحمد عاقبته، قال الجليح:
إنّي إذا الجِبس على الكور انثنى |
لو سئل الماءُ فداءً لافتدى |
|
وقال: كم أتعبت؟! قلت: قد أرى |
عند الصّباح يحمد القوم السُّرى |
وتنجلي عنه عمايَّات الكرى) (3)
(يضرب للرجل يحتمل المشقّة رجاء الراحة) (4) . (مثل يضرب لمتحمل المشقّة العاجلة رجاء الراحة الآجلة) (5) . اختلف في قائله وقد عرفت نسبته إلى الخالد، وقيل: هو للجليح، وقيل: للأغلب العجلي، أو غيرهم.
وكيف كان فقد
____________________
(1) النهج 9: 233، 161/ط.
(2) الفاخر 193 - 194.
(3) المستقصي 2: 168.
(4) المجمع 2: 3 حرف العين.
(5) شرح النهج 9: 234.
بان معنى المثل في مورده الأول. وأمّا تمثّل الإمام (عليه السّلام) به عند ترقيع مدرعته التي تعدل جبب السلاطين وألبستهم المزيّفة، بل لا قياس بينها وجميع ما في الدنيا، فلوهن المادّة وصغرها في عينه ولاقتداء الفقراء به قال ذلك، قيل له لِمَ ترقّع قميصك؟! قال (عليه السّلام): (ليخشع القلب ويقتدي به المؤمنون) (1) .
قيل: كان راقعه ابنه الحسن (عليه السّلام)، أو أهله، ومن هنا قال (عليه السّلام): (حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَاقِعِهَا). لا يستطيع واصف يصف زهده، فعلى شيعته الاقتداء به والاستضاءة بنور علمه وتقوى الله (عزّ وجلّ) كما كان هو كذلك.
____________________
(1) المصدر: 235.
باب الفاء
الفاء مَعَ الألف
28 - فاعِلُ الخَيْرِ خَيْرٌ مِنْهُ ، وفاعِلُ الشَّرِ شَرٌّ مِنْهُ (1) .
يماثل المثل الذي ضربه (عليه السّلام) أو هو هو بتغيير ما ما ذكره الميداني: (إنّ خيراً من الخير فاعله، وإنّ شراً من الشّر فاعله) وقال: هذا المثل لأخ للنعمان بن المنذر يقال له علقمة، قاله لعمرو بن هند في مواعظ كثيرة، كذا ذكره أبو عبيد في كتابه) (2) .
وللشارح شعر وبيان، قال:
(قد نظمت أنا هذا اللفظ والمعنى فقلت في جملة أبيات لي:
خير البضائع للانسان مكرمة |
تنمى وتزكو إذا بارت بضائعه |
|
فالخير خير وخير منه فاعله |
والشّر شّر وشّر منه صانعه |
فإن قلت: كيف يكون فاعل الخير خيراً من الخير وفاعل الشّر شراً من الشّر، مع أنّ فاعل الخير إنّما كان ممدوحاً لأجل الخير، وفاعل الشّر إنّما كان مذموماً لأجل الشّر، فإذا كان الخير والشّر هما سببا المدح والذّم، وهما الأصل في ذلك، فكيف يكون فاعلاهما خيراً وشرّاً منهما؟
قلت: لأنّ الخير والشّر ليسا عبارة عن ذات حيّة قادرة، وإنّما هما فعلان، أو فعل وعدم فعل، أو عدمان. فلو قطع النظر عن الذات الحيّة القادرة التي يصدران عنها، لما انتفع أحدٌ بهما ولا استضّر، فالنفع والضّر إنما حصلا من الحيّ الموصوف بهما لا منهما على انفرادهما، فلذلك كان فاعل الخير خيراً من الخير، وفاعل الشّر شر من الشّر) (3) .
____________________
(1) النهج 18: 149، 32/ح.
(2) مجمع الأمثال 1: 58 حرف الهمزة.
(3) شرح النهج 18: 149.
ويؤيّده من بعض الوجوه أنّ العلم إنّما يقوم بأهله، وكذا الجهل لا يكون إلاّ بالجاهل، فالعلم والجهل بما هما لا وجود لهما، وهكذا الصدق والكذب، وقد جاء: (أحسن من الصدق قائله، وخير من الخير فاعله) (1) ، (وهل الخير قبل الشّر) كما في الخبر (2) .
وهنا بحوث لا تسع المقام.
____________________
(1) السفينة 1: 432 في (خير).
(2) مصابيح الأنوار 1: 111 فيه إشارة إليه.
باب القاف
القاف مَعَ الدّال
29- قَدْ أضَاءَ الصُّبحُ لِذي عَينَيْن ِ (1) .
(هذا الكلام جار مجرى المثل ومثله: (والشمس لا تخفى عن الإبصار)، ومثله: (إن الغزالة لا تخفى عن البصر) .
وقال ابن هانئ يمدح المعتز:
فاسْتَيْقظوا من رَقْدَةٍ وتَنَبّهوا |
ما بالصّباحِ عن العيونِ خفَاء |
|
ليستْ سماءُ اللّهِ ما تَرَوْنَها |
لكنّ أرضاً تحتويهِ سَماء) (2) |
قال الميداني: (قد بَيَّنَ الصبح لذي عينين: بَيَّنَ هنا بمعنى تَبَيَّنَ، يضرب للأمر يظهر كلّ الظهور) (3) .
وذكره العسكري أيضاً وقال: (يضرب مثلاً للأمر ينكشف ويظهر) (4) .
فالمثل الجاري الذّي ضربه الإمام (عليه السّلام) متّحد مع المثل السائر مع تغيير ما في لفظه. وهل المقصود من الانكشاف لجميع خلافتُه الكبرى المنصوص عليها بنصّ الغدير، حيث جمع الرّسول (صلّى الله عليه وآله) الناس عند الوصول إلى هذا المكان، وقد نزل عليه جبرائيل بقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ ) (5) ، ( وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوًّا ) (6) .
____________________
(1) النهج 18: 395، 171/ح.
(2) المصدر.
(3) مجمع الأمثال 2: 99 حرف القاف.
(4) الجمهرة على هامش مجمع الأمثال 2: 135 حرف القاف.
(5) سورة المائدة الآية 67.
(6) سورة النمل الآية 14.
وهكذا ولْده الأحد عشر الأوصياء المعصومون، نصّت على وصايتهم النصوص المعتبرة كما ذكرها علماؤنا في مجامعهم والجمهور: (أنّ الأئمة من قريش يملكها اثنا عشر منهم) (1) ، وحديث الثقلين الدالّ على أنّ من لم يتمسّك بالكتاب وعترته أهل بيته ضالّ والمتمسّك غير ضالّ، ذلك بأنّ أهل البيت (عليهم السّلام) معهم الشرائع من الحلال والحرام، بل وجميع أحكام الإسلام، وبعد ذلك على الأمّة الرجوع إليهم والأخذ عنهم (عليهم السّلام) في كلّ شيء؟
____________________
(1) مسند أحمد 5: 86 - 88.
باب الكاف
الكاف مَعَ اللاّم
30- كَلَعْقَةِ لاعِق ٍ (1) .
من كتاب له (عليه السّلام) إلى أهل البصرة أوّله: (وقَدْ كَانَ مِنِ انْتِشَارِ حَبْلِكُمْ وشِقَاقِكُمْ مَا لَمْ تَغْبَوْا عَنْهُ، فَعَفَوْتُ عَنْ مُجْرِمِكُمْ... ولَئِنْ أَلْجَأْتُمُونِي إِلَى الْمَسِيرِ إِلَيْكُمْ لأوقِعَنَّ بِكُمْ وَقْعَةً لا يَكُونُ يَوْمُ الْجَمَلِ إِلَيْهَا إِلاَّ كَلَعْقَةِ لاعِقٍ...).
شقاق أهل البصرة مع أمير المؤمنين معروف وجاء ذمّهم على لسانه (عليه السّلام) غير مرّة، وكفى شقاقاً يوم الجمل. والكلام تهديد لتكرير الشقاق والخلاف منهم أنّه (عليه السّلام) يوقع وقعة هي أمّر وأدهى من يوم الجمل، بل لا يكون القياس إلى الوقعة المتوّقعة إلاّ بمثل لعقة لاعق.
قال الشارح: ( كَلَعْقَةِ لاعِقٍ : مثل يضرب للشيء الحقير التافه، ويروى بضّم اللام، وهي ما تأخذه الملعقة) (2) .
في الحديث: (الويل لمَن باع معاده بلعقة لم تبق). اللعقة (بالفتح) المرة، من لعِقتُ الشيء (بالكسر) ألعقه لعقاً، أي لحسته، ومنه الأصابع.
ومن كلام له (عليه السّلام) في أمر الخلافة وتأخيره عنها: (وهل هي إلاّ كلعقة الآكل ومذقة الشارب وخفقة الوسنان، ثم تلزمهم المعرات)، ومثله قوله (عليه السّلام): (مصادرين أحدكم لعقة على لسانه، صنيع من قد فرغ من عمله وأحرز رضى سيّده)، ومثله قوله (عليه السّلام) في خلافة مروان (إنّ له إمرةً كلعقة الكلبِ أنْفَهُ) لأنّ خلافته كانت ستة أشهر (3) .
____________________
(1) نهج البلاغة الخطبة رقم: 45.
(2) نهج البلاغة خطبة المتقين (خطبة همام).
من ذلك كلّه عرف أنّ المثل المذكور يضرب للأمر التافه وللقلّة. وقد يأتي من لفظه لما لم يكن له حقيقة ثابتة، كقول الإمام الحسين (عليه السّلام) في كلام له: (الدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درّت معائشهم، فإذا محصّوا بالبلاء قلّ الدّيانون) (1) .
____________________
(1) حياة الإمام الحسين (عليه السّلام) 3: 97.
الكاف مَعَ الميم
31- كَما تَدِينُ تُدانُ (1) .
من خطبة له (عليه السّلام) أوّلها: (وهُو فِي مُهْلَةٍ مِنَ اللَّهِ يَهْوِي مَعَ الْغَافِلِينَ... وضَعْ فَخْرَكَ، واحْطُطْ كِبْرَكَ، واذْكُرْ قَبْرَكَ فَإِنَّ عَلَيْهِ مَمَرَّكَ، وكَمَا تَدِينُ تُدَانُ، وكَمَا تَزْرَعُ تَحْصُدُ...).
عن الإمام الصادق (عليه السّلام) قال: (كانت امرأة على عهد داود يأتيها رجل يستكرهها على نفسها فألقى الله (عزّ وجلّ) في قلبها فقالت له: إنّك لا تأتيني مرّة إلاّ وعند أهلك من يأتيهم، قال: فذهب إلى أهله فوجد عند أهله رجلاً، فأتى به داود (عليه السّلام) فقال: يا نبيّ الله، وجدت هذا الرجل عند أهلي، فأوحى الله إلى داود قل له: كما تدين تدان) (2) .
وعنه (عليه السّلام) أنّ الله أوحى إلى موسى (عليه السّلام) (لا تزنوا فتزني نسائكم، ومن وطئ فراش امرئ وُطِئ فراشُه: كما تدين تدان) (3) .
من هنا يعلم أنه مثل سماويّ، وأثبتناه نحن في الأمثال النبويّة (4) . وأثبته الأدباء عن ابن دريد، عن أبي حاتم، عن أبي عبيدة، قال: (كان ملك من ملوك غسّان ينقدر النساء، لا يبلغه عن امرأةٍ جمالُ إلاّ أخذها، فأخذ ابنة يزيد بن الصعق وكان أبوها غائباً، فلمّا قَدِم أُخبّر، فوفد على الملك
____________________
(1) النهج 9: 158، 153/ط.
(2) الوسائل 14: 269.
(3) الوسائل 14: 236. و271.
(4) في حرف الكاف.
فصادفه منتدياً، وكان الملك إذا تبدّى لم يحجب عنه أحد، فوقف منذ تحيّته يسمع كلامه، فقال: يا أيّها الملك المقيت، أما ترى ليلاً وصبحاً كيف يختلفان؟! هل تستطيع الشمس أن تؤتى بها ليلاً وهل لك بالمليك يدان؟! واعلم وايقن أنّ ملكك زائل! واعلم بأنّ كما تدين تدان، فأجابه الملك:
إنّ الّتي سلبت فؤادك خطّة |
مرفوضة فاصبر لها ابن كلاب |
|
فارجع بحاجتك التي طالبتها |
والْحَق بقومك في هضاب إراب |
ثم نادى: إنّ هذه سنة مرفوضة.
قال أبو عبيدة: ما أنشدت هذه الأبيات ملكاً ظالماً إلاّ كفته عن غربه ومعنى المثل كما تفعل يفعل بك) (1) .
____________________
(1) هامش المستقصي 2: 231. [نقل بتلخيص وتصرّف] قوله: ينقدر النساء في نفس المصدر: لعلّه يقذّر النساء. أقول: لعلّه يغدر بالنساء.
32 - كَمْ مِنْ أكْلَةٍ تَمنَعُ أَكلات ٍ (1) .
من كلمات الإمام القصار المعدودة من الأمثال جاءت بلفظ (ربّ أكلة تمنع أكلات) في كتب الأمثال.
قال المفضّل:
(أوّل من قال ذلك عامر بن الظرب العدواني، وكان من حديثه أنّه كان يدفع النّاس في الحج، فرآه ملك من ملوك غسّان فقال: لا أترك هذا العدواني حتّى أذلّه. فلمّا رجع ذلك الملك إلى منزله أرسل إليه: أحبّ أن تزورني فأحبوك وأكرمك وأتخذّك خليلاً. فأتاه قومه فقالوا: تفد ويفد معك قومك فيصيبون في جنبك ويتجيهون بجاهك. فخرج وأخرج معه نفراً من قومه، فلمّا قدم بلاد الملك أكرمه وأكرم قومه، ثم انكشف له رأى الملك، فجمع أصحابه وقال: الرأي نائم والهوى يقظان، ومن أجل ذلك يغلب الهوى الرأي. عجلتُ حين عجلتم، ولن أعود بعدها. إنّا قد تورّطنا بلاد هذا الملك فلا تسبقوني بريث أمر أقيم عليه، ولا بعجلة رأي أخفّ معه، فإنّ رأيي لكم. فقال قومه: قد أكْرَمَنا كما ترى، وبعد هذا ما هو خير منه. فقال: لا تعجلوا فإنّ لكلّ عام طعاماً وربّ أكلة تمنع أكلات...) (2) .
والميداني: (يضرب في ذمّ حرص الطعام...) وسَرَدَ القصة (3) .
والعسكري: (يضرب مثلاً للخصلة من الخير تنال على غير وجه الصواب فتكون سبباً لمنع أمثالها) ثم أشار إلى ما تقدّم من قول المفضّل (4) .
____________________
(1) المهج 18: 397، 173/ح.
(2) الفاخر 174.
(3) المجمع 1 / 297 حرف الراء.
(4) الجمهرة على هامش مجمع الأمثال 1: 319.
من وجوه منع الأكلة الأكلات عدم مضغها كما ينبغي، والمضغ مما يمري الطعام الذي لا يجّر مرضاً معه. إذا الطاعم أكل عند الجوع ورفع اليد عنه وهو يشتهي، وأجاد المضغ، لم يشتك وجعاً. ومنها: كبر اللقمة. ومنها: العجلة في الأكل وسرعة الابتلاع. ومنها عدم التعّهد لما يأكل (ربّ أكلة هاضت الآكل ومنعته مآكل):
كم أكلةٍ خامرتْ حشا شرهٍ |
فأخرجت روحَه من الجسدِ (1) |
____________________
(1) شرح النهج 18: 397.
الكاف مَعَ النّون
33 - كَناقِشِ الشَّوكَةِ بِالشَّوْكَةِ (1) .
من كلام له (عليه السّلام) وقد قام إليه رجل من أصحابه فقال: نهيتنا عن الحكومة ثم أمرتنا بها! فما ندري أي الأمرين أرشد. فصفق (عليه السّلام) إحدى يديه على الأخرى ثم قال: (هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْعُقْدَةَ. أَمَا واللَّهِ لَو أَنِّي حِينَ أَمَرْتُكُمْ بِمَا أَمَرْتُكُمْ، حَمَلْتُكُمْ عَلَى الْمَكْرُوهِ الَّذِي يَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً: فَإِنِ اسْتَقَمْتُمْ هَدَيْتُكُمْ، وإِنِ اعْوَجَجْتُمْ قَوَّمْتُكُمْ، وإِنْ أَبَيْتُمْ تَدَارَكْتُكُمْ، لَكَانَتِ الْوُثْقَى، ولَكِنْ بِمَنْ وإِلَى مَنْ أُرِيدُ أَنْ أُدَاوِيَ بِكُمْ وأَنْتُمْ دَائِي "كَنَاقِشِ الشَّوْكَةِ بِالشَّوْكَةِ" وهُو يَعْلَمُ أَنَّ ضَلْعَهَا مَعَهَا!!).
أثبتنا صدر الكلام لربط التمثيل.
قال المعتزلي :
(وهذا مثل مشهور: (لا تنقش الشوكة بالشوكة، فإنّ ضلعها معها) والضلع الميل، يقول: لا تستخرج الشوكة الناشبة في رجلك بشوكة مثلها فإنّ إحداهما في القوة والضعف كالأخرى، فكما أنّ الأولى انكسرت لمّا وطئتها فدخلت في لحمك فالثانية إذا حاولت استخراج الأولى بها تنكسر وتلج في لحمك) (2) .
قال الزمخشري بعد المثل:
(ويروي: فإنّ (ألبها). والمعنى ميلها: يضرب في النهي عن الاستعانة بمن هو للمطلوب منه الحاجة أنصح منه للطالب) (3) .
أوردناه في الأمثال النبوّية (4) .
والغرض من التمثيل به هنا يعرف
____________________
(1) النهج 7: 291، 130/كلام.
(2) شرح النهج 7: 294.
(3) المستقصي 2: 260.
(4) في حرف اللام مع الألف.
من قبله، حيث قال (عليه السّلام): (أَنْ أُدَاوِيَ بِكُمْ وأَنْتُمْ دَائِي) فأصحابه يزيدون في علّته بدل أن يرفعونها؛ لأنّ حادثة التحكيم لم تحدث إلاّ من قبلهم فكيف يعمل في رفعها بسبب هؤلاء وهم قد أوجدوها، فحالهم وحال الإمام (عليه السّلام) كمعالجة إخراج الشوكة أخرى تزيدها ولوجاً.
34 - كَناقِلِ التَّمْرِ إلى هَجَر َ (1) .
مثل سائر. من كتاب له (عليه السّلام) جواباً إلى معاوية، وهو من محاسن الكتب، أوّله:
(أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ أَتَانِي كِتَابُكَ تَذْكُرُ فِيهِ اصْطِفَاءَ اللَّهِ مُحَمَّداً...).
ثم قال (عليه السّلام):
(فَلَقَدْ خَبَّأَ لَنَا الدَّهْرُ مِنْكَ عَجَباً إِذْ طَفِقْتَ تُخْبِرُنَا بِبَلاءِ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَنَا، ونِعْمَتِهِ عَلَيْنَا فِي نَبِيِّنَا، فَكُنْتَ فِي ذَلِكَ كَنَاقِلِ التَّمْرِ إِلَى هَجَرَ أَو دَاعِي مُسَدِّدِهِ إِلَى النِّضَالِ...).
وإنّما تمثّل الإمام (عليه السّلام) في جواب معاوية المعدِّد لنعم الله تعالى على أهل البيت (عليهم السّلام)، ردّاً له بأنّ: (أهل البيت أدرى بما فيه) و(أهل مكّة أعرف بشعابها)، وليس معاوية في بيان نعم الله على آل محمد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وتعدادها إلاّ كمستبضع التمر إلى بلدة (هجر)، التّي ينقل منها التمر لا إليها كما عبّر بعض عن المثل الجاري بـ (كمستبضع التمر إلى هجر).
قال النيسابوري بعد المثل بلفظه الأخير: قال أبو عبيد: هذا من الأمثال المبتذلة ومن قديمها، وذلك أنّ (هجر) معدن التمر، والمستبضع إليه مخطئ... قال النابغة الجعدي:
وإنَّ امرأً أهْدَى إلَيْكَ قَصَيْدةً |
كَمُسْتَبْضِع تَمْرَاً إلَى أرضِ خَيْبَرَ) (2) |
قال المعتزلي : (مثل قديم. وهَجَر اسم مدينة لا ينصرف للتعريف والتأنيث. وقيل: هو اسم مذكّر مصروف... والنسبة: هاجريّ، على غير قياس. وهي بلدة كثيرة النخل يحمل منها التمر إلى غيرها، قال الشاعر في هذا المعنى:
____________________
(1) النهج 15: 181، 28/ك.
(2) مجمع الأمثال 2: 152 - 153 حرف الكاف.
أهدى له طَرَفَ الكلامِ كما |
يُهدَى لواليِ البصرةِ التمْرِ |
(قوله (عليه السّلام): (أَو دَاعِي مُسَدِّدِهِ إِلَى النِّضَالِ) أي معلّمه الرمي، وهذا إشارة إلى قول القائل الأوّل:
أعلّمه الرماية كلّ يوم |
فلمّا استدّ ساعده رماني) (1) |
من كلمة السديد لا الشديد.
____________________
(1) شرح النهج 15: 188 - 189.
باب اللاَّم
اللاّم مَعَ الألف
35 - لا رَأيَ لِمَنْ لا يُطاع ُ (1) .
من خطبة له (عليه السّلام) في الجهاد أوّلها:
(أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ... نَهَضْتُ فِيهَا ومَا بَلَغْتُ الْعِشْرِينَ وهَا أَنَا ذَا قَدْ ذَرَّفْتُ عَلَى السِّتِّينَ، ولَكِنْ "لا رَأْيَ لِمَنْ لا يُطَاعُ").
أول من قاله عتبة بن ربيعة حين اجتمعت قريش للمسير إلى بدر، وهو مأخوذ من قول الشاعر:
أَمَرتُهُمُ أَمري بِمُنعَرَجِ اللِوى |
وَلا أَمرَ لِلمَعصِيِّ إلاّ مُضَيَّعا (2) |
والمراد من نفي الرأي عند عدم الطاعة الغرض المترتّب على اتّباعه لا نفيه رأساً. وكلمة (لا) النافية للجنس تقتضي النفي رأساً، ولكن لأجل القرينة الخارجيّة من عقل أو نقل يصرف ظهورها عن اقتضائها في ذلك كما قال الفقهاء في: (لا صلاة لمن جاره المسجد) أنّ المنفي فيها الكمال، لا الصلاة رأساً حتى يحكم عليها بالبطلان إذا صلاّها المصلّي في غير المسجد. فكأنّ الذي لم يتّبع رأيه ولم يطع، فاقد له رأساً. وكان (عليه السلام) في طوال خمس وعشرين سنة جليس بيته لم يُطع رأيه، وهو (عليه السّلام) واجد له بالذات، فالمثل جاء من باب المبالغة في عدم تحقّق الأهداف السامية عند تركهم طاعة الإمام (عليه السّلام) من أمرهم بجهاد العدوّ الألدّ كمعاوية بن أبي سفيان ومن يحذو حذوه، وفي جميع الأدوار والعصور لم تحصل للأنبياء من أممهم الطاعة على سبيل العموم.
____________________
(1) النهج 2: 75، 27/ط.
(2) الجمهرة على هامش مجمع الأمثال 2: 276 حرف اللام.
وهكذا أوصياهم (عليهم السّلام)، وإلاّ لازدهرت الأيّام ولعمّت السعادة، فقد جرى في هذه الأمّة ما جرى في السلف (القّذة بالقّذة) كما جاء الحديث في تفسير قوله تعالى: ( لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ) (1) ، فلا جرم أنّ صاحب الخلافة الكبرى أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال هذه المقالة تحسّراً عليهم من قلب ملؤه حبّ وحنان، وعن يقين أنّ في الطاعة نجاتهم وفي الخلاف هلاكهم. ولا يقول قائل هذا الكلام إلاّ تحسّراً على فوت الهدف الأفضل بالعصيان، وعلماً منه بالعاقبة المحمودة بالطّاعة.
____________________
(1) الانشقاق 84: 19، تفسير البرهان 4: 443.
اللاّم مَعَ الباء
36- لَبِّثْ قَليْلاً يَلْحَقِ الهَيْجا حَمَل ُ (1) .
تمثّل (عليه السّلام) بالرجز لكلام له في جواب معاوية من فقرة: (وذَكَرْتَ أَنَّهُ لَيْسَ لِي ولِأَصْحَابِي عِنْدَكَ إِلاَّ السَّيْفُ، فَلَقَدْ أَضْحَكْتَ بَعْدَ اسْتِعْبَارٍ، مَتَى أَلْفَيْتَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنِ الأعْدَاءِ نَاكِلِينَ وبِالسَّيْفِ مُخَوَّفِينَ؟!
«فَلَبِّثْ قَلِيلاً يَلْحَقِ الْهَيْجَا حَمَلْ» |
....................................) |
والرجز لحمل بن بدر القشيري صاحب الغبراء - أغير على إبله في الجاهليّة فاستنقذها وقال:
فَلَبِّثْ قَلِيلاً يَلْحَقِ الْهَيْجَا حَمَلْ |
لا بَأسَ بالمَوْتِ إذا الموتُ نَزَلْ (2) |
وفي لفظ:
..................................... |
ما أحسَنَ الموتَ إذا حَانَ الأجَلْ |
(قالوا في (حمل) هو اسم رجل شجاع كان يُستظهر به في الحرب. ولا يبعد أن يراد به: حمل بن بدر صاحب الغبراء، يضربه من ناصِرُه وراءه) (3) .
لم يرْتَب اثنان من البشر في شجاعة أمير المؤمنين (عليه السّلام)، تشهد لها حروبه ومواقفه الجبّارة في حياة الرسول الأعظم (صلّى الله عليه وآله) وبعد مماته. وكيف لا وهو معلّم الشجعان فنون الحرب؟! ومعاوية يقول هذه المقالة وهو يعلم أن لا مقاومة له ولا لجنوده وعشيرته للمقتولين بيد الإمام (عليه السّلام)، بل ولا العرب كلّها عند ضربة عليّ (عليه السّلام)، وهو
____________________
(1) النهج 15: 184، 28/ك.
(2) رسالة الإسلام: 126 (عدد 7 - 8).
(3) المستقصي 2: 278.
القائل: (واللَّهِ، لَو تَظَاهَرَتِ الْعَرَبُ عَلَى قِتَالِي لَمَا وَلَّيْتُ عَنْهَا ولَو أَمْكَنَتِ الْفُرَصُ مِنْ رِقَابِهَا لَسَارَعْتُ إِلَيْهَا...) (1) .
وإنما قالها لتخذير أفكار أصحابه المغفّلين، بل معاوية يدري أنّ صاحب أمير المؤمنين (عليه السّلام) مالك الأشتر مبيد له وما يملك من أهل الشام، وكان الأمر كذلك لولا حادثة التحكيم من جهلة الأصحاب من زهاء عشرين ألف نهرواني.. والحديث ذو شجون. وقد شابهت محنته (عليه السّلام) محنة هارون حيث طلب أصحاب موسى (عليه السّلام) منه أن يجعل العجل لهم إلهاً كما لهم آلهة... ولا حول ولا قوة إلاّ بالله.
____________________
(1) النهج 16: 289.
اللاّم مَعَ الجيم
37- لَجَمَلُ أَهْلِكَ ، وشَسْعُ نَعْلِكَ، خَيْرٌ مِنْكَ (1) .
تمثّل الإمام (عليه السّلام) بالمثل المذكور من كتاب له إلى المنذر بن الجارود العبدي، وقد كان استعمله على بعض النواحي، فخان الأمانة في بعض ما وّلاه من أعماله: (... ولَئِنْ كَانَ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ حَقّاً، "لَجَمَلُ أَهْلِكَ وشِسْعُ نَعْلِكَ خَيْرٌ مِنْكَ"...).
قال الشريف الرضي (طاب ثراه):
(المنذر بن الجارود هذا هو الذي قال فيه أمير المؤمنين (عليه السّلام) (إنّه لنَظَّارٌ في عَطْفَيْه، مُخْتَالٌ في بُرْدَيْه، تَفّالٌ في شِرَاكَيه).
استعرض جمع من أرباب التراجم ترجمته، ولئن لم يكن في قدحه إلاّ ما جاء في كلام الإمام (عليه السّلام) لكفى. ولا يهّمنا الترجمة. وكلّ من كان على صفته وشاكلته شملَه القدحُ المذكور: أنّ جَمَل أهله، وشسع نعله، خير منه.
ونظيره المثل النبوّي المروّي: (رُبَّ مَرْكُوْبٍ خَيْرٌ مِن رَاكِبِه) (2) فخائن الأمانة، الراكب الجمل أو النعل، مركوبه خير منه؛ لأنه لم يخن.
قال المعتزلي في الشرح:
(العرب تضرب بالجمل المثل في الهوان، قال:
لَقَد عَظُمَ البَعيرُ بِغَيرِ لُبِّ |
وَلَم يَستَغنِ بِالعِظَمِ البَعيرُ |
|
يُصَرِّفُهُ الصَبيُّ بِكُلِّ وَجهٍ |
وَيَحبِسُهُ عَلى الخَسفِ الجَريرُ |
|
وَتَضرِبُهُ الَوليدَةُ بِالهَراوى |
فَلا غِيَرٌ لَدَيهِ وَلا نَكيرُ |
فأمّا شسع النعل، فضرب المثل بها في الاستهانة مشهور لابتذالها
____________________
(1) النهج 18: 54، 71/ك.
(2) المجازات النبويّة 315 رقم 355.
ووطئها الأقدام في التراب) (1) .
ثم وجوب ردّ الأمانة، وحرمة الخيانة ثابت بالأدّلة الأربعة: الكتاب والسّنة والعقل والإجماع. ولا فرق في ذلك بين القّلة والكثرة، ولو كان كمثل إبرة أو أقلّ منها. وما قاله (عليه السّلام) (2) لابن عبّاس لما بلغه منه أن لو كان من الحسن والحسين (عليهما السّلام) لانتقم منهما، يغني عن البحث.
____________________
(1) شرح النهج 18: 58.
(2) النهج 16: 167 - 168، 41/ك.
اللاّم مَعَ العين
38 -
لِعَمْرِ أَبيكَ الخَيْرُ يا عَمْروُ إِنَّني |
|
عَلى وَضَرٍ مِنْ ذا الإِناءِ قَليلٌ (1) . |
من خطبة له (عليه السّلام) وقد تواترت عليه الأخبار باستئلاء أصحاب معاوية على البلاد وقدم عليه عاملاه على اليمن وهما عبيد الله بن عبّاس وسعيد بن نمران لمّا غلب عليهما بسر بن أرطاة فقام على المنبر ضجراً بتثاقل أصحابه عن الجهاد، ومخالفتهم له في الرأي فقال:
(مَا هِيَ إِلاَّ الْكُوفَةُ أَقْبِضُهَا وأَبْسُطُهَا إِنْ لَمْ تَكُونِي إِلاَّ أَنْتِ تَهُبُّ أَعَاصِيرُكِ فَقَبَّحَكِ اللَّهُ).
وتمثّل بقول الشاعر:
(«لَعَمْرُ أَبِيكَ الْخَيْرِ يَا عَمْرُو إِنَّنِي |
عَلَى وَضَرٍ مِنْ ذَا الإنَاءِ قَلِيلِ»). |
والبيت من الطويل.
والغرض من التمثّل به يُعرف من كلامه (عليه السّلام) قبله، أي قبل البيت: (مَا هِيَ إِلاَّ الْكُوفَةُ...) أنّها لديه (عليه السّلام) كالوضَرَ القليل في الإناء، وهو غسالة الشيء وبقيّة الدسم، أي لم يبق من البلاد والعباد له سوى الكوفة، وهي مهدّدة بجيش الشام؛ لخذلان أصحابه بنهوضهم للجهاد مع العدّو، واستيلاء ابن أرطاة من قبل معاوية على اليمن وقتل أهلها، وهي من الحوادث الممضّة. وهكذا كان (أرواحنا فداه) أيّام خلافته ممتحناً بالفتن وخذلان صحبه، وأهل الكوفة أهل الغدر والتخذيل، وكثيراً ما كان (عليه السّلام) يستنهضهم لجهاد العدّو فلم ينهضوا بالحرّ والقرّ. كانوا يقولون: حتّى تنقضي حمّارة الحرّ أو قرص البرد. وهو يخوّفهم نار جهّنم وغيرها من ألوان عذاب الله الأكبر فلم يتخوّفوا، فهو (عليه السّلام) أوّل مظلوم في العالم قبل خلافته وبعدها (عليه السّلام).
____________________
(1) النهج 1: 332، 25/ط.
اللاّم مَعَ الواو
39 - لَوْ يُطاع ُ لِقصيرٍ أَمْرٌ (1) .
من خطبة أولّها: (الْحَمْدُ لِلَّهِ وإِنْ أَتَى الدَّهْرُ بِالْخَطْبِ الْفَادِحِ).
إلى قوله (عليه السّلام):
(وقَدْ كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ فِي هَذِهِ الْحُكُومَةِ أَمْرِي، ونَخَلْتُ لَكُمْ مَخْزُونَ رَأْيِي، "لَو كَانَ يُطَاعُ لِقَصِيرٍ أَمْرٌ"...).
والمثل من قصّة مشهورة ضربت فيها عدّة أمثال هو منها، ذكرها الأدباء بتفصيل. منها صاحب (رسالة الإسلام)، قال:
(قاله قصير بن سعد اللخمي لجذيمة الأبرش عندما أشار عليه ألاّ يستجيب إلى الزباء - ملكة الجزيرة - حينما كتبتْ إليه في أن يقبل إليها لتضّم ملكها إلى ملكه، وكانت تنوي من وراء ذلك الغدر به لأنّه كان قد وترها بقتله أباها، فلم يقبل جذيمة مشورة قصير وذهب إليها، فقال قصير: لو يطاع لقصير أمر. وكانت نهاية الأمر أن قتلت الزباء جذيمة وأدركت ثأرها (2) .
والقصّة هذه من أحفل القصص في الأمثال التي قيلت خلال حوادثها، فقد بلغت واحداً وعشرين مثلاً:... رأيٌ فاتر وغدرٌ حاضر، رَأْيُكَ في الْكِنِّ لا في الضحِّ، لا يطاع لقصير أمر، ببقَّةَ خَلَّفْتُ الرأي، القول رداف، خطب يسير، لا يشّق غباره، ويل أمّه... خير ما جاءت به العصا...
واستشهد الإمام (عليه السّلام) بالمثل المذكور حيث نصح جماعته بعدم قبول التحكيم في وقعة صفّين وأبوا عليه ذلك (3) . والمحدّث القمّي (رحمه الله) أثبت المثل وقصّته من نصح قصير مولى جذيمة وبعثة الزباء
____________________
(1) النهج 2: 204، 35/ط.
(2) مجمع الأمثال حروف الخاء.
(3) العدد السابع والثمن وسنة ثانية ص 114 - 115.
إليه ليتزّوج بها فخرج في ألف فارس وخلّف باقي جنوده مع ابن أخيه.. (1) .
وهو مثل يضرب لمن خالف نصح الناصح، وما أكثر من نزول الويل على من ترك نصح ذي الحجى وحلول الندامة عند معصية ذوي الرأي والإشفاق؟! وهل كان أحد أسدّ من الأمير (عليه السّلام) رأياً وأكثر إشفاقاً على الرعيّة. وإنّ حادثة التحكيم المفروض منهم على الإمام (عليه السّلام) لمن أمرِّ الحوادث وأشدّها على الإسلام والمسلمين من جرّاء العصيان والتمرّد.
____________________
(1) السفينة 2: 431
باب الميم
الميم مَعَ الألف
40 - مَا عَدا مِمَّا بَدا (1) .
جاء المثل في آخر كلام له (عليه السّلام) لما أنفذ عبد الله بن عبّاس إلى الزبير قبل وقوع الحرب يوم الجمل ليستفيئه إلى طاعته:
(لا تَلْقَيَنَّ طَلْحَةَ فَإِنَّكَ إِنْ تَلْقَهُ تَجِدْهُ كَالثَّوْرِ عَاقِصاً قَرْنَهُ، يَرْكَبُ الصَّعْبَ، ويَقُولُ هُو الذَّلُولُ. ولَكِنِ الْقَ الزُّبَيْرَ فَإِنَّهُ أَلْيَنُ عَرِيكَةً، فَقُلْ لَهُ: يَقُولُ لَكَ ابْنُ خَالِكَ عَرَفْتَنِي بِالْحِجَازِ وأَنْكَرْتَنِي بِالْعِرَاقِ "فَمَا عَدَا مِمَّا بَدَا").
قال الرضي (رحمه الله):
(وهو (عليه السّلام) أوّل من سمعت منه هذه الكلمة أعني: (فَمَا عَدَا مِمَّا بَدَا)).
كتبها كلّ من الميداني (2) والمفضل (3) وغيرهما ناسبين لها إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام)، وهي صالحة للمثل، بل هي هو.
قال القطب الراوندي:
(قوله: (فَمَا عَدَا مِمَّا بَدَا) له معنيان:
أحدهما: ما الذي منعك مما كان قد بدا منك من البيعة قبل هذه الحالة.
الثاني: ما الذي عاقك، ويكون المفعول الثاني لـ (عدا) محذوفاً يدل عليه الكلام، أي ما عداك. يريد: ما شغلك وما منعك ممّا كان بدا لك من نصرتي) (4) .
وقيل:
(المعنى: ما الذي صدّك عن طاعتي بعد إظهارك لها. وحذفُ الضمير المفعول المنصوب كثيرٌ جدّاً، كقوله تعالى: ( وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
____________________
(1) النهج 2: 162، 31/كلام.
(2) المجمع 2: 296 حرف الميم.
(3) الفاخر 1 - 3.
(4) شرح النهج 2: 164.
مِنْ رُسُلِنَا ) (1) : أي أرسلناه) (2) .
يمكن كونه مثلاً سائراً تمثّل الإمام به، أو من باب توارد الخواطر، أو من كلمات قصار صالحة للمثل كما تقدم. قيل: أجاب زبير بعد إبلاغه:
(أبلغه سلامي وقل له: عهد خليفة، ودَم خليفة، وإجماع ثلاثة، وانفراد واحد وأمّ مبرورة، ومشاورة العشيرة...) (3) .
____________________
(1) سورة الزخرف: الآية 45.
(2) شرح النهج 2: 164.
(3) الفاخر 301 (بتصرف طفيف).
الميم مَعَ التّاء
41 - والْمُتَعَلِّقُ بِهَا كَالْوَاغِلِ الْمُدَفَّعِ والنَّوْطِ الْمُذَبْذَبِ (1) .
من كتاب له (عليه السّلام) إلى زياد بن أبيه وقد بلغه أنّ معاوية كتب إليه يريد خديعته باستخلافه:
(وقَدْ كَانَ مِنْ أَبِي سُفْيَانَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلْتَةٌ مِنْ حَدِيثِ النَّفْسِ، ونَزْغَةٌ مِنْ نَزَغَاتِ الشَّيْطَانِ، لا يَثْبُتُ بِهَا نَسَبٌ ولا يُسْتَحَقُّ بِهَا إِرْثٌ و"الْمُتَعَلِّقُ بِهَا كَالْوَاغِلِ الْمُدَفَّعِ والنَّوْطِ الْمُذَبْذَبِ").
قال الرّضي (رحمه الله):
(قوله (عليه السّلام): (الْوَاغِل) هو الذي يهجم على الشرب ليشرب معهم وليس منهم فلا يزال مدّفعاً محاجزاً، و(النَّوْط الْمُذَبْذَبِ): هو ما يناط برحل الراكب من قعب أو قدح أو ما أشبه ذلك، فهو أبداً يتقلقل إذا حثّ ظهره واستعجل سيره.
وقيل:
(الواغل: غير المدعوّ إلى وليمة، المعبّر عنه بـ: الطفيل. لا يزال يدفع بإخراجه عن ذلك) (2) .
قوله (عليه السّلام) (فَلْتَةٌ): (الفلتة: وقوع الأمر من غير تدّبر ولا روّية، وكلّ شيء يفعله الإنسان فجأة من غير تدبّر ولا روّية، ومنه قول عمر: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرّها (3) .
ومراده (عليه السّلام) من فلتة أبي سفيان قَولته في تبنّي زياد وأنه ولده. لا يثبت بهذا القول بنّوةٌ في ظاهر الشرع، يتوارث عليها. فشبّهه (عليه
____________________
(1) النهج 16: 177، 44/ك.
(2) هامش بعض نسخ النهج.
(3) مجمع البحرين في (فلت) [بتصرُّف].
السلام) المتعلّق بها كمن يهجم على ورد ماء ليس من أصحابه، فيدفع عنه ويمنع عن ورود الورد أشّد المنع، أو كمن علّق على دابته قعباً أو قدحاً متقلقلاً أبداً، وكِلا التمثيلين لمدّعى بنوّة من لا يكون له، كأبي سفيان بدعوة بنوّة زياد ولزياد نفسه.
الميم مَعَ الثّاء
42 - مَثَلُ آلِ مُحمَّد ٍ كمَثَلِ نُجومِ السَّماءِ (1) .
في آخر خطبة له (عليه السّلام) (... أَلا إِنَّ مَثَلَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَثَلِ نُجُومِ السَّمَاءِ "إِذَا خَوَى نَجْمٌ طَلَعَ نَجْمٌ").
تمثيلهم (عليهم السّلام) بالنجوم تكرّر في أحاديثهم، كما جاء عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ما يطابق ذلك.
روى الشيخ الصدوق بسنده إلى ابن عبّاس في حديث قال:
(قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): (... ومثلكم مثل النجوم كلمّا غاب نجم طلع نجم إلى يوم القيامة) (2) .
إذا جهل السالكون الطريق في الليل المظلم اهتدوا بنجوم السماء كما قال تعالى: ( وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) (3) بإضاءتها وانتظام الساكنة والسائرة منها، حيث يستدلّ بوضعها على قطاع الأرض المنقسمة إلى أقاليمها السبعة، وعلى أبعاض الليل وساعاته. والناس إذا جهلوا، والجهل أصلهم حيث أخرجوا من بطون أمّهاتهم لا يعلمون شيئاً كما في الآية (4) ، افتقروا إلى الإضاءة في السلوك إلى الله تعالى إلى هداة يهدونهم سبل السلام؛ من هنا جاء تمثيلهم (عليهم السّلام) بالنجوم ووقع في محلّه!
والمشابهة بين أهل البيت (عليهم السّلام) والنجوم من وجوه: هي الإضاءة، وامتدادها بقيام إمام عند موت إمام كطلوع نجم إذا خوى نجم،
____________________
(1) النهج 7: 84، 99/ط.
(2) الأمالي 238.
(3) سورة النحل الآية 16.
(4) سورة النحل الآية 78.
والرفعة المختصة بهم (عليهم السّلام) التّي اختارها الله تعالى لهم لا يشاركهم غيرهم فيها، وسرور الناظر إلى نجوم الولاية كما يسُرّه إذا نظر إلى نجوم السماء، وغيرها من وجوه لا تحصل بتمثيل الشمس والقمر وإن جاء في دعاء الندبة: (أين الشموس الطالعة، والأقمار المنيرة) (1) وغير الدعاء، لاختلاف وجهة الأهداف من التمثيل. وإن شئت الوصول إلى واقع التمثيل، فابحثْ عن لزوم الحجّة في الأرض واستحالة خلّوها عند العقول والفطرة السليمة التّي تؤيّدها صحاح الأخبار أنّه لو خلت عن الحجّة لساخت بأهلها (2) .
____________________
(1) مفاتيح الجنان، الشيخ عباس القمي.
(2) أصول الكافي 1: 178.
43 - مَثَلُ الدُّنيَا كَمَثلِ الْحَيَّةِ (1) .
قال (عليه السّلام): ("مَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ الْحَيَّةِ" لَيِّنٌ مَسُّهَا والسَّمُّ النَّاقِعُ فِي جَوْفِهَا يَهْوِي إِلَيْهَا الْغِرُّ الْجَاهِلُ ويَحْذَرُهَا ذُو اللُّبِّ الْعَاقِلُ).
يشابه المثل المثلَ الآخر منه (عليه السّلام) في كتاب له كتبه إلى سلمان الفارسي (رحمه الله) قبل أيّام خلافته: (أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّمَا مَثَلُ الدُّنْيَا مَثَلُ الْحَيَّةِ: لَيِّنٌ مَسُّهَا، قَاتِلٌ سَمُّهَا. فَأَعْرِضْ عَمَّا يُعْجِبُكَ فِيهَا لِقِلَّةِ مَا يَصْحَبُكَ مِنْهَا، وضَعْ عَنْكَ هُمُومَهَا...) (2) .
لا يفتقر المثلان إلى توضيح بعد القدر المشترك بين الحيّة والدّنيا في إهلاك مزاولهما وأنّهما عدّو الإنسان والعاقل يكون على حذر دائماً منهما.
يقول أبو العتاهية:
إِنَّما الدَهرُ أَرقَمٌ لَيِّنُ المَس |
وَفي نابِهِ السَقامُ العَقامُ (3) |
وتجد الإمام (عليه السّلام) يمثّل الدنيا بما يحذّر الناس من اعتناقها إلاّ بقدر الحاجة، والقرآن الكريم والسنّة النبويّة وتمام روايات أهل البيت (عليهم السّلام) تحذّرهم عنها غاية التحذير، وقد جاء في الحديث: (حبّ الدنيا رأس كلّ خطيئة) (4) .
وجاءت في الكتاب والسنّة تمثيلاتٌ للدّنيا ببيت العنكبوت، والعجوز، والبحر العميق،
____________________
(1) النهج 18: 284، 115/ح.
(2) النهج 18: 34، 68/ك.
(3) شرح النهج 18: 284.
(4) الوسائل 11: 308.
وفصول السنة، والماء النازل من السماء، والخضرة.... وكلّ ذلك يشهد له الواقع، وكان عمل الإمام (عليه السّلام) وزهده في الدنيا، بل وعمل أهل البيت (عليهم السّلام) وزهدهم فيها يجسّد التحذير عنها أكثر منه من القول؛ لأنّ العمل يترك في النفوس من الأثر غير الوصف.
44 - مَثَلُ مَنْ خَبَرَ الدُّنْيا كمَثَلِ قَوْمٍ سَفْرٍ (1) .
في وصيّته لابنه الحسن (عليهما السّلام) مثلان ضربهما لمن خبر الدنيا ولمن اعتّر بها.
قال (عليه السّلام):
(إِنَّمَا "مَثَلُ مَنْ خَبَرَ الدُّنْيَا كَمَثَلِ قَوْمٍ سَفْرٍ" نَبَا بِهِمْ مَنْزِلٌ جَدِيبٌ فَأَمُّوا مَنْزِلاً خَصِيباً وجَنَاباً مَرِيعاً، فَاحْتَمَلُوا وَعْثَاءَ الطَّرِيقِ وفِرَاقَ الصَّدِيقِ وخُشُونَةَ السَّفَرِ وجُشُوبَةَ المَطْعَمِ لِيَأْتُوا سَعَةَ دَارِهِمْ ومَنْزِلَ قَرَارِهِمْ، فَلَيْسَ يَجِدُونَ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَلَماً، ولا يَرَوْنَ نَفَقَةً فِيهِ مَغْرَماً، ولا شَيْءَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِمَّا قَرَّبَهُمْ مِنْ مَنْزِلِهِمْ وأَدْنَاهُمْ مِنْ مَحَلَّتِهِمْ. ومَثَلُ مَنِ اغْتَرَّ بِهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ كَانُوا بِمَنْزِلٍ خَصِيبٍ فَنَبَا بِهِمْ إِلَى مَنْزِلٍ جَدِيبٍ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِمْ، ولا أَفْظَعَ عِنْدَهُمْ، مِنْ مُفَارَقَةِ مَا كَانُوا فِيهِ إِلَى مَا يَهْجُمُونَ عَلَيْهِ ويَصِيرُونَ إِلَيْهِ).
في المثلين شرح كافٍ، وقد كثر ضرب الأمثال للدنيا وأهلها في الكتاب والسنّة؛ تحذيراً عن سوء المغّبة وترغيباً إلى رفضها والإقبال على الله (عَزَّ وجَلَّ). وفي ضرب المثل في التحذير أو الترغيب بما يجسّد المحذَّر منه أو المرغَّب فيه ما لا يحصل بغيره، وهكذا سائر الدّواعي والأغراض.
قوله (عليه السّلام): ((نَبَا): يقال: نبا عنه بصره ينبو: أي تجافى ولم ينظر إليه. وبنا به منزله، إذا لم يوافقه) (2) .
(يقول: مثل من عرف الدنيا وعمل فيها للآخرة كمن سافر من منزل
____________________
(1) النهج 16: 82، 31/الوصية.
(2) نهاية ابن الأثير في (نبا).
جدب إلى منزل خصيب فلقى في طريقه مشقّة، فإنّه لا يكترث بذلك في جنب ما يطلب. وبالعكس من عَمَل للدنيا وأهمل أمر الآخرة، فإنّه كمن سافر إلى منزل ضنك ويهجر منزلاً رحيباً طيّباً) (1) .
____________________
(1) شرح النهج 16: 83.
الميم مَعَ الرّاء
45 - المَرأْةُ رَيحَانةٌ وَلَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ (1) .
جاء المثل في وصيّته لابنه الحسن (عليهما السّلام):
(ولا تُمَلِّكِ الْمَرْأَةَ مِنْ أَمْرِهَا مَا جَاوَزَ نَفْسَهَا فَإِنَّ "الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ ولَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ" ولا تَعْدُ بِكَرَامَتِهَا نَفْسَهَا ولا تُطْمِعْهَا فِي أَنْ تَشْفَعَ لِغَيْرِهَا).
في الوصيّة عدّة أمور ترتبط بالمرأة:
منها: المنع من إدخالها في الشئون المعاشيّة التي يقوم بها الرجل؛ تبنى على الأغلب على صعوبة وخشونة لا تلائم نعومة المرأة وضعفها الذّاتيّ؛ ولأجلها قال (عليه السّلام): (فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ ولَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ).
ومنها: المنع عمّا يمسّ كرامتها من ذهابها إلى اجتماعات رجاليّة أو نسائيّة، فإنّ المرأة تسعى غالباً فيما فيه زينتها وتسويل نفسها.
ومنها: المنع عن الشفاعة لغيرها؛ إذ لا تكون فكرتها ترجع إلى دين المشفوعة.
ومنها: ترك مشاركتها في المشورة، والأمر بشّدة حجابها.
وإلى الأخيرَيْن أشار (عليه السّلام) في الوصيّة بقوله: (وإِيَّاكَ ومُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ؛ فَإِنَّ رَأْيَهُنَّ إِلَى أَفْنٍ، وعَزْمَهُنَّ إِلَى وَهْنٍ. واكْفُفْ عَلَيْهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ بِحِجَابِكَ إِيَّاهُنَّ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحِجَابِ أَبْقَى عَلَيْهِنَّ. ولَيْسَ خُرُوجُهُنَّ بِأَشَدَّ مِنْ إِدْخَالِكَ مَنْ لا يُوثَقُ بِهِ عَلَيْهِنَّ. وإِنِ اسْتَطَعْتَ أَلا يَعْرِفْنَ غَيْرَكَ فَافْعَلْ) (2) .
ثم التمثيل بالريحانة يقصد منه اللّذة والتّمتع وسكون الرجل إليها،
____________________
(1) النهج 16: 122، 31/الوصية.
(2) المصدر.
وضمان حياته الثانية بالولد الذي يبقى الوالد به وإن كان ميّتاً. فلأمرٍ أهمّ خُلقت: من تربية أولاد، وإدارة شئون داخليّة هي وسائل الثقة، وفراغ البال لعبادة الله تعالى، الغاية من الخلق كما قال (عزّ وجلّ): ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ) (1) ؛ ومن هنا وجبت النفقة على الرجل حتّى لا تهتمّ بشيء سوى ما تقدّم.
____________________
(1) سورة والذاريات: الآية 56.
46- الْمَرأةُ عَقْرَبٌ حُلوَةُ اللَّسِبَةِ (1) .
من تمثيلاته (عليه السّلام).
اللّسبة: اللسعة. لَسَبَتْه العقربُ (بالفتح): لَسَعَتْهُ. ولَسِبْتُ العسلَ، أي لَعِقْتَه) (2) .
جاءت عدّة تمثيلات في مدح المرأة وقدحها:
من الأوّل : (المرأة ريحانة وليست بقهرمانة) (3) ، (المرأة لعبة) (4) ، (النساء شقائق الرجال) (5) .
ومن الثاني: (المرأة مثل الضلع المعوّج إن تركته انتفعت به) (6) .
هي الضلعُ العَوْجاءُ لستَ تُقِيْمَها |
ألا إنّ تقويمَ الضلوعِ انكسارُها |
|
أيجمعنَ ضَعفاً واقْتِداراً على الفتى |
أليس عجيباً ضعفُها واقتدارُها؟! |
(المرأة شرّ كلّها، وشرّ ما فيها أنّه لابدّ منها) (7) .
إنّ النساءَ كأشجارٍ نبتنٍ معاً |
هُنَّ المرارُ وبعضُ المرِّ مأكولُ |
|
إنّ النساءَ متى يُنْهَيْنَ عن خُلِقٍ |
فإنّه واجبٌ لابدّ مفعولُ (8) |
قيل: إنّ كيد النساء أعظم من كيد الشيطان لأنّ الله تعالى ذكر الشيطان فقال: ( إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ) (9) ، وذكر النساء فقال: ( إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ) (10) .
والجواب: أنّ ضعف كيد الشيطان إنّما هو في جنب الله تعالى، وعظم كيد النساء بالقياس إلى الرجال.
وبعد ذلك كلّه، أنّه لولا النساء لما كان الرجال وإنْ افترقن عنهم بفروق.
____________________
(1) النهج 18: 198، 59/ح.
(2) المصدر.
(3) عيون ابن قتيبة 4: 79.
(4) الوسائل 14: 119.
(5) نهاية ابن الأثير في (شفق).
(6) الوسائل 14: 123.
(7) النهج 19: 69، 235/ح.
(8) النهج 18: 200.
(9) سورة النساء الآية 76.
(10) سورة يوسف الآية 28.
الميم مَعَ السّين
47 –
مُسْتَقْبِلين رِيَاحَ الصَّيفِ تَضْرِبُهُم |
|
بحَاصِبٍ بَيْنَ أَغوارٍ وَجَلمُود (1) |
تمثلّ (عليه السّلام) بهذا البيت في كتابه إلى معاوية جواباً عن كتابه:
(أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّا كُنَّا نَحْنُ وأَنْتُمْ عَلَى مَا ذَكَرْتَ مِنَ الأُلْفَةِ والْجَمَاعَةِ، فَفَرَّقَ بَيْنَنَا وبَيْنَكُمْ أَمْسِ أَنَّا آمَنَّا وكَفَرْتُمْ... وذَكَرْتَ أَنَّكَ زَائِرِي فِي الْمُهَاجِرِينَ والأنْصَارِ، وقَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ يَوْمَ أُسِرَ أَخُوكَ فَإِنْ كَانَ فِيهِ عَجَلٌ فَاسْتَرْفِهْ، فَإِنِّي إِنْ أَزُرْكَ فَذَلِكَ جَدِيرٌ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ إِنَّمَا بَعَثَنِي إِلَيْكَ لِلنِّقْمَةِ مِنْكَ، وإِنْ تَزُرْنِي فَكَمَا قَالَ أَخُو بَنِي أَسَدٍ:
«مُسْتَقْبِلِينَ رِيَاحَ الصَّيْفِ تَضْرِبُهُمْ |
بِحَاصِبٍ بَيْنَ أَغْوَارٍ وجُلْمُودِ»). |
(الحاصب لقوم لوط، وهي ريح عاصف فيها حصباء، والحصباء: صغار الحصى. والأغوار: جمع غور، والغور: ما بين ذات عرق إلى البحر غور تهامة، فتهامة أوّلها ذات عرق من قبل نجد إلى مرحلتين من وراء مكّة وما وراء ذلك فهو الغور. وجلمود أو جلمد كجعفر وعصفور: الصخر، ميمه زائدة) (2) وقيل: الغور الغبار.
وحصيلة كلام الإمام (عليه السّلام) تكذيب معاوية أن يكون معه مهاجر أو ناصر بانقطاع الهجرة بأسر أخيه يزيد بن أبي سفيان في باب الخندمة، بل الذين معه هم أبناء الطلقاء، فإن زرتك فأنا نقمة الله عليك وإن زرتني فأنت كأرياح الصيف لا فائدة فيها سوى ضرب الوجوه بصغار الحصى
____________________
(1) النهج 17: 250، 64/ ك.
(2) مجمع البحرين: في (حصب، وغور، وجلمد) [ملخَّصاً].
والغبار، أو بين الصخور من أراضي تهامة، أي زيارتك شرّ كلّها.
قال المعتزلي :
(كنت أسمع قديماً أنّ هذا البيت من شعر بشر بن أبي حازم الأسدي والآن قد تصفحت شعره فلم أجده ولا وقفت على قائله) (1) .
وكيف كان فالمثل منطبق على كلّ من فيه صفة معاوية مهما كان نوعه فزيارة المنافقين كلّها شرّ لا خير فيها، إذ لم يرد بها وجه الله (عَزَّ وجَلَّ)، وليست هي من رَوْح الله كزيارة المؤمنين.
____________________
(1) رسالة الإسلام 127 (عدد 7 - 8).
الميم مَعَ النّون
48 - مَنْ سَلَكَ الطَّريق َ الواضِحَ وَرَدَ المَاءَ (1) .
من كلام له (عليه السّلام) يجري مجرى الأمثال:
(... أَيُّهَا النَّاسُ، "مَنْ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوَاضِحَ وَرَدَ الْمَاءَ"، ومَنْ خَالَفَ وَقَعَ فِي التِّيهِ).
والتيه: المفازة لا يهتدي سالكها.
ونظير المثل المثل: ((مَنْ سَلَكَ الجَدَدَ أمِنَ العِثَار) الجدد الأرض المستوية. ويروى: (مَنْ تَجَنَّبَ الخَبَار..)، وهي أرض رخوة تتعتع فيها الدّوابّ، يضرب لطالب العافية) (2) .
إرشاد منه (عليه السّلام) يلمسه كلّ أحد يرشد به أصحابه ويحذّرهم عن سلوك ما يعطبون به. وأمره (عليه السّلام) أوضح من كلّ واضح، إن تمسّك متمسّك به نجا ومن خالفه هلك، وقد جاء الحديث النبويّ: (مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق) (3) .
والمراد بالتمثيل ليس هو مجرّد الولاء لأهل البيت (عليهم السّلام) فقط، بل لابدّ من العمل بما يقولون ويحبّون والاتباع المورث لحبّ الله تعالى كما قال تعالى: ( قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ ) (4) . وعليه فالمثل واقع موقعه؛ إذ إنّ السالك الطريق الواضح يصل إلى ما يقصده من سلوكه، والمنحرف عنه يفوته وليس له إلاّ التعب أو العطب.
وقد أتمّ الله الحجّة على النّاس وبلّغها أنبياؤه وبلغ إيّاها الرّسول وأوصياؤه المعصومون (صلّى الله عليهم وسلّم)، وبعد ذلك كلّه إمّا أن يشكروا أو يكفروا كما قال تعالى: ( وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ) (5) ، هما طريق الشّر
____________________
(1) النهج 10: 261، 194/كلام.
(2) المستقصي 2: 356.
(3) حرف الميم من الأمثال النبويّة .
(4) سورة البلد الآية 10.
والخير، وقال تعالى: ( إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ) (1) ، ( قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ) (2) . الأنبياء والأوصياء والشّرائع السماويّة هي الحجج الظاهرة، والعقول الموهبة للنّاس وما فطروا عليه من المعرفة به تعالى ودينه الحجج الباطنة، فقد تمّت رسل الله من خارج وداخل ( ِلئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ) (3) .
____________________
(1) سورة الإنسان الآية 3.
(2) سورة الأنعام الآية 149.
(3) سورة النساء الآية 165.
49 - مَنْ لاَنَ عُودُه كَثُفَتْ أَغْصانُهُ (1) .
ذكروا:
(أنّ من حَسُنَ خلقُه ولاَنتْ كلمته كَثُر محبّوه وأعوانه وأتباعه، ونحوه: (مَنْ لاَنتْ كلِمَتْهُ وَجَبَتْ مَحَبَّتُهُ)، وقال تعالى: ( وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ) (2) . وأصل هذه الكلمة مطابق للقواعد الحكميّة - أعني الشجرة ذات الأغصان - حقيقة، وذلك لأنّ النبات كالحيوان في القوى النفسانيّة، أعني الغاذّية والمنميّة، وما يخدم الغاذّية من القوى الأربع، وهي: الجاذبة والماسكة والدافعة والهاضمة، فإذا كان اليَبْس غالباً على شجرة، كانت أغصانها أخفّ وكان عودها أدّق. وإذا كانت الرطوبة غالبة، كانت أغصانها أكثر وعودها أغلظ، وذلك لاقتضاء اليبس الذبول، واقتضاء الرّطوبة الغلظ والعبالة والضخامة، ألا ترى أنّ الإنسان الذي غلب اليبس على مزاجه لا يزال مهلوساً نحيفاً، والذي غلبت الرطوبة عليه لا يزال ضخماً عبلاً) (3) .
في الصادقيّ: (يا شيعة آل محمّد، اعلموا أنّه ليس منّا من لم يملك نفسه عند غضبه، ومن لم يحسن صُحبةَ من صحبه، ومخالقة من خالقه، ومرافقة من رافقه، ومجاورة من جاوره، وممالحة من مالحه. يا شيعة آل محمّد، اتقوا الله ما استطعتم ولا قوّة إلاّ بالله).
وعنه (عليه السّلام) في قول الله (عَزَّ وجَلَّ): ( إِنَّا نَرَاكَ مِنْ الْمُحْسِنِينَ ) (4) ، قال: (كان يوسِّع المجلس، ويستقرض للمحتاج، ويعين الضعيف) (5) .
____________________
(1) النهج 19: 35، 210/ح.
(2) سورة آل عمران الآية 159.
(3) شرح النهج 19: 35.
(4) سورة يوسف الآية 36.
(5) أصول الكافي 2: 637.
والقرآن الكريم يأمر بحسن القول ويرّغب إلى فضائل ومكارم الأخلاق، قال تعالى: ( وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ) (1) ، ( وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) (2) ، ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) (3) . وكلام الإمام (عليه السّلام) ترغيب إلى ذلك مع بيان الوجه فيه كما تقدّم بتفصيل لسرّ التمثيل.
____________________
(1) سورة البقرة الآية 83.
(2) سورة القلم الآية 4.
(3) سورة الأحزاب الآية 21.
50 - مَنْ مَلَكَ اسْتَأْثَر َ (1) .
من الأمثال السائرة، جاء به الإمام (عليه السّلام) لإرشاد ذوي المناصب أو من تصدّى أمراً من الأمور المخوّلة إليه.
قال الميداني : ((مَنْ مَلَكَ اسْتَأثَرَ) يضرب لمن يلي أمراً فيُفْضِل على نفسه وأهله فيُعَابُ عليه فعله) (2) .
قال الشارح:
(المعنى: أنّ الأغلب في كلّ مَلِكٍ يستأثر على الرّعية بالمال والعزّ والجاه. ونحو هذا المعنى قولهم: (مَنْ غَلَبَ سَلَبَ)، و(مَنْ عَزَّ بَزَّ) (3) . ونحوه قول أبي الطيّب:
الظُلمُ مِن شِيَمِ النُفوسِ فَإِن تَجِد |
ذا عِفَّةٍ فَلِعِلَّةٍ لا يَظلِمُ (4) |
ومن ثَمَّ الإمام أمير المؤمنين (عليه السّلام) عندما ولى الخلافة ونصب ولاته على الأقطار والأمصار كانت كتبه ورسائله تترى عليهم في حين، وحين يحذّرهم عن الاستيثار أشدّ التحذير ويحاسبهم على الذّرة والدّرة. وإذا بلغه عنهم أمر يخالف ما أراد وما أمرهم به، عزل المخالف من ساعته وعاقبه عقاب الله (عَزَّ وجَلَّ) وأجرى عليه حدوده ولا تأخذه في الله لومة لائم. ومن طالع سيرته (عليه السّلام) مع الولاة المنصوبين من قبله علم صدق ذلك كلّه، ويكفيك قضيّة واليه ابن عبّاس وما بلغه من تصرّفه من بيت المال: (وواللَّهِ لَو أَنَّ الْحَسَنَ والْحُسَيْنَ فَعَلا مِثْلَ الَّذِي فَعَلْتَ، مَا كَانَتْ لَهُمَا عِنْدِي هَوَادَةٌ ولا ظَفِرَا مِنِّي
____________________
(1) النهج 18: 381، 162/ح.
(2) مجمع الأمثال 2: 32 حرف الميم.
(3) المستقصي 2: 357.
(4) شرح النهج 18: 381.
بِإِرَادَةٍ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُمَا وأُزِيحَ الْبَاطِلَ عَنْ مَظْلَمَتِهِمَا) (1) .
ولينظر الناظر إلى مالك الأشتر حين ولاّه على مصر وما شرح له من وظائف الولاة وطبقات الرّعية (2) .
____________________
(1) النهج 16: 168.
(2) النهج 17: 30 - 117، 53/ك.
51- مَنهُومانِ لا يَشْبَعانِ : طالِبُ عِلمٍ، وَطالِبُ دُنْياً (1) .
يطابق الكلمة ما روي عن النّبي (صلّى الله عليه وآله) وتمامه: (فمن اقتصر من الدنيا على ما حلّ الله له سلم، ومن تناولها من غير حلّها هلك إلاّ أن يتوب أو يراجع. ومن أخذ العلم من أهله وعمل بعلمه نجا، ومن أراد به الدّنيا فهي حظّه) (2) .
(النَّهْمة: بلوغ الهِمَّة في الشيء، ومنه (النَّهَمُ من الجُوع)) (3) (والنَّهم (بالفتح): إفراط الشهوة في الطعام) (4) .
والكلمة جارية. من الأحاديث المَثَليّة، يلهج بها المسلمون عند رؤية طالب علم أو دنيا واستمرار طلبهما، يجدّان طيلة الحياة كأنّهما جائعان لا يشبعان. هذا ليس له همّ إلاّ دنيا يصيبها وتصيبه، لم يأتلف إلاّ مع من يعتلف منها، ولا عشيق له غيرها، قد أشرب قلبه من حبّها فاغترّ بغرورها حتّى مات وصار إلى جهنّم وبئس المصير.
أمّا طالب العلم، فهو ممّن أُلقى في روعه داعية الخير وطلبه، قد قصر همّه وهمته على معرفة الحقائق والحقوق، وأحقّها من بين ذلك كلّه معرفة الباري (عَزَّ وجَلَّ) وصفاته وأفعاله وأسمائه الجلاليّة والجماليّة، ومعرفة أنبيائه وأوصيائهم، وشرائهم النازلة من السماء الّتي تضمن بيان دنيا الإنسان ودينه.
____________________
(1) النهج 20: 174، 466/ح.
(2) أصول الكافي 1: 46.
(3) نهاية ابن الأثير.
(4) شرح النهج 20: 174.
ولو أحبّ أحد أن يعرف جوع طالبي الدنيا والعلم على امتداد حياتهما، نظر إلى العلماء وما نقل عنهم من سهر الليالي في مطالعة الكتب. وكان أحدهم ربّما ذهب الليل كلّه وهو مكبّ على الكتاب لم يحسّ بذهابه. وإنّي لأعرف من كان يقوم من ثلثي الليل في كلّ ليله يقضيه بين مطالعة وكتابة وتهجّد والقوم نائمون، ومن أهل الدنيا من اشتدّ طلبه لها، لم ينم كلّ الليل بين كتابة ومحاسبة من أخذ منه أو أعطى أو على ظهر السفر في برّ أو بحر، وقد أُمر الناس بإجمال طلب الرزق لا التفاني فيه.
52- مَنْ وَثَقَ بِالماء ِ لَمْ يَظْمأْ (1) .
هذا المثل من خطبة نصّها:
(بِنَا اهْتَدَيْتُمْ فِي الظَّلْمَاءِ وتَسَنَّمْتُمْ ذُرْوَةَ الْعَلْيَاءِ، وبِنَا أَفْجَرْتُمْ عَنِ السِّرَارِ. وُقِرَ سَمْعٌ لَمْ يَفْقَهِ الْوَاعِيَةَ. وكَيْفَ يُرَاعِي النَّبْأَةَ مَنْ أَصَمَّتْهُ الصَّيْحَةُ؟! رُبَّ جَنَانٌ لَمْ يُفَارِقْهُ الْخَفَقَانُ. مَا زِلْتُ أَنْتَظِرُ بِكُمْ عَوَاقِبَ الْغَدْرِ وأَتَوَسَّمُكُمْ بِحِلْيَةِ الْمُغْتَرِّينَ... الْيَوْمَ أُنْطِقُ لَكُمُ الْعَجْمَاءَ ذَاتَ الْبَيَانِ. عَزَبَ رَأْيُ امْرِئٍ تَخَلَّفَ عَنِّي. مَا شَكَكْتُ فِي الْحَقِّ مُذْ أُرِيتُهُ. لَمْ يُوجِسْ مُوسَى (عليه السلام) خِيفَةً عَلَى نَفْسِهِ، بَلْ أَشْفَقَ مِنْ غَلَبَةِ الْجُهَّالِ ودُوَلِ الضَّلالِ. الْيَوْمَ تَوَاقَفْنَا عَلَى سَبِيلِ الْحَقِّ والْبَاطِلِ. "مَنْ وَثِقَ بِمَاءٍ لَمْ يَظْمَأْ"...).
اشتملت الخطبة الشريفة على عدّة أمثال لا تخفى على الأريب.
قيل:
(إنّ هذه الأمثال ملتقطة من خطبة طويلة منسوبة إليه (عليه السّلام)).
- قوله (عليه السّلام) (وبِنَا أَفْجَرْتُمْ عَنِ السِّرَارِ) إسرار: الليلة والليلتان يستتر فيهما القمر في آخر الشهر فلا يظهر.
- (وُقِرَ سَمْعٌ لَمْ يَفْقَهِ الْوَاعِيَةَ) دعاء على السمع الذي لا يسمع الصرخة، أي العبر والمواعظ.
- (كَيْفَ يُرَاعِي النَّبْأَةَ مَنْ أَصَمَّتْهُ الصَّيْحَةُ؟!) مثل آخر. النبأة: الصوت الضعيف، أي من لم ينتفع بالمواعظ الجلية كيف ينتفع بالخفيّة منها.
- (رُبَّ جَنَانٌ لَمْ يُفَارِقْهُ الْخَفَقَانُ) مثل آخر، وهو دعاء لقلب لم يفارقه الخفقان من خشية الله تعالى.
- (الْيَوْمَ أُنْطِقُ لَكُمُ الْعَجْمَاءَ ذَاتَ الْبَيَانِ) مثل آخر، يريد (عليه السّلام) تمثيل الرموز الخفيّة الغامضة في كلامه - وهي مع غموضها جليّة لذوي النهي - بالبهم الصامتة الناطقة بدلائل الصنع ووجود بارئها (جلّ جلاله).
نظير المثل:
رسل الأرض، من شق أنهارك وأخرج ثمارك؟، فإن
____________________
(1) النهج 1: 207، 4/ط.
لم تجبك حواراً أجابتك اعتباراً.
- قوله (عليه السّلام): (لَمْ يُوجِسْ مُوسَى خِيفَةً عَلَى نَفْسِهِ) تمثّل بقوله تعالى: ( فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ) (1) . يقول (عليه السّلام): كما خاف موسى (عليه السّلام) على ضلال قومه كذلك أنا خائف على تغلّب الجهالة على قومي وإحاطة الضلالة بهم. وهذا مثل قرآني.
- (الْيَوْمَ تَوَاقَفْنَا عَلَى سَبِيلِ الْحَقِّ والْبَاطِلِ) بقراءة تقديم القاف على الفاء، أي اتّضح الحق والباطل ووقفنا عليهما نحن وأنتم وعرفناهما حقّ المعرفة. - قوله (عليه السّلام): (مَنْ وَثِقَ بِمَاءٍ لَمْ يَظْمَأْ) لم يرد (عليه السّلام) نفي الظمأ إطلاقاً؛ لأنّ الواثق بالماء قد يظمأ كالعطشان الواجد للماء، وقد تمثّل لهذا المعنى بقول أبي الطيب:
وَما صَبابَةُ مُشتاقٍ عَلى أَمَلٍ |
مِنَ اللِقاءِ كَمُشتاقٍ بِلا أَمَلِ |
والصائم في شهر الله يصبح جائعاً تنازعه نفسه إلى الطعام، وفي أيام فطره لا يجد تلك المنازعة في نفسه؛ ذلك بأنّ النفس حريصة على ما منعت منه.
وهذا المثل من الأمثال الرفيعة السائرة، يريد (عليه السّلام) بالماء: الموثوق به نفسه الشريفة المقدّسة. إنّه الماء المعين الزلال للواثقين به (عليه السّلام) السالكين مسلكه، والمعوّل في كلّ المعضلات، حتى قال قائل عندما دهمته معضلة: (إنّها معضلة لها أبو الحسن)، أو (ليس لها إلاّ أبا الحسن عليّ (عليه السّلام)). وإنّه الهداية لا ضلال بعدها، والنصير الذي لا يخذل مستنصِره. والبحر الزاخر. عن أبي هريرة قال: كنت عند النّبي (صلّى الله عليه وآله) إذ أقبل عليّ بن أبي طالب، فقال النّبي: (هذا البحر
____________________
(1) سورة طه الآية 67.
الزاخر، هذا الشمس الطالعة. أسخى من الفرات كفاً، وأوسع من الدنيا قلباً، ومن أبغضه فعليه لعنة الله) (1) .
إنه الوسيلة إلى الله تعالى في نجح الطلبات والفوز بالمهمّات، والثقة الكاملة في جميع أمور الدين والدنيا حيّاً وميّتاً على ما ذهبت إليه الشيعة الإماميّة. وكذا بقيّة الأئمّة الأحد عشر من نسله الطاهر والصديقة الطاهرة، الحجج المعصومين (صلوات الله عليهم وسلّم)، والنهر العظيم رسول الله (صلّى الله عليه وآله).
ويعجبني الحديث الآتي:
روى الشيخ الكليني (طاب ثراه) عن محمد بن يحيى، عن أحمد، عن علي بن النعمان رفعه، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: قال أبو جعفر (عليه السّلام): (يمصّون الثماد ويدعون النهر العظيم). قيل له: و ما النهر العظيم؟ قال: (رسول الله والعلم الذي أعطاه الله. إنّ الله (عزّ وجلّ) جمع لمحمد سُنن النبيّين من آدم وهلّم جرّاً إلى محمد). قيل له: وما تلك السنن؟ قال: (علم النبيين بأسره وأنّ رسول الله صيّر ذلك كلّه عند أمير المؤمنين). فقال له رجل: يا ابن رسول الله، فأمير المؤمنين أعلم أم بعض النبيّين؟ فقال أبو جعفر: (اسمعوا ما يقول؟! إنّ الله يفتح مسامع من يشاء!! إنّي حدّثته أنّ الله جمع لمحمد علم النبيّين وأنّه جمع ذلك كلّه عند أمير المؤمنين، وهو يسألني أهو أعلم أم بعض النبيّين!!) (2) .
____________________
(1) السفينة 2: 712 في هرر.
(2) الكافي 2: 222 - 223.
53 - المِنَيَّةُ وَلاَ الدَّنْيَّة ُ (1) .
قال (عليه السّلام):
(المنّية ولا الدنيّة، والتقلقل ولا التوسّل) قال الشاعر:
أقسم بالله لمصّ النوى |
وشرب ماء القُلُبِ المالحة |
|
أحسن بالإنسان من ذلّه |
ومن سؤال الأوجه الكالحة |
|
فاستغن بالله تكن ذا غنى |
مغتبطاً بالصّفقة الرابحة |
|
فالزهد عزّ والتقى سؤدد |
وذلّة النفس لها فاضحة |
|
كم سالم صِيح به بغتةٍ |
وقائلٍ عهدي به البارحة |
|
أمسى وأمستْ عنده قنية |
وأصبحت تندبه ناحية |
|
طوبى لمن كانت موازينه |
يوم يلاقي ربّه راجحة |
وقال أيضاً:
لمصّ الثماد وخرط القتاد |
وشرب الأُجاج أوآنَ الظّما |
|
على المرء أهون من أن يرى |
ذليلاً لخلق إذا أعدما |
|
وخير لعينيك من منظر |
إلى ما بأيدي اللئام العمى (2) |
ذكر المثل جمع، منهم الميداني، قال: (المنيّة ولا الدنيّة) أي أختارُ المنيّة على العار. ويجوز الرفع، أي: المنيّة أحبّ إليّ ولا الدنيّة، أي: وليستُ ممّا أحبّ واختارُ. قيل المثل: لأوس بن حارثة (3) . وممّن أصدقها قولاً وفعلاً الحسين بن علي كأبيه (عليهما السّلام)، قال (عليه السّلام) يوم
____________________
(1) النهج 19: 362، 404/ح.
(2) شرح النهج 19: 362.
(3) مجمع الأمثال 2: 303 حرف الميم.
كربلاء:
(ألا وإنّ الدّعي ابن الدّعي قد ركز بين اثنتين: بين السلّة والذلّة، وهيهات منّا الذّلة، يأبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وأنوف حميّة ونفوس أبيّة أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام) (1) .
وقال (عليه السّلام) أيضاً:
(لا أرى الموت إلاّ سعادة والحياة مع الظالمين إلاّ برما) (2) .
وإنّ ذلك من شيم أصحابهم فضلاً عنهم (عليهم السّلام)، ولم تكن الدنيّة توجد إلاّ عند أهلها أهل الأطماع محتملي الضيم. وأمّا من لا يحتمل ضيماً، ففيه قال القائل:
ويركب حدّ السيف من لا يضيمه |
إذا لم يكن عن شفرة السيف مرحل (3) |
____________________
(1) اللهوف 38.
(2) اللهوف 30.
(3) الجمهرة على مجمع الأمثال 2: 210.
باب الهاء
الهاء مَعَ النّون
54 -
هُنالِكَ لَوْ دَعَوْتَ أتاكَ مِنْهُمْ |
|
فَوارِسُ مِثْلَ أَرْمِيَةِ الحَميمِ (1) |
من آخر خطبة له (عليه السّلام) وقد تواترت عليه الأخبار باستيلاء معاوية على البلاد، حيث قال (عليه السّلام) في آخرها:
(اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ مَلِلْتُهُمْ ومَلُّونِي، وسَئِمْتُهُمْ وسَئِمُونِي، فَأَبْدِلْنِي بِهِمْ خَيْراً مِنْهُمْ وأَبْدِلْهُمْ بِي شَرّاً مِنِّي. اللَّهُمَّ مِثْ قُلُوبَهُمْ كَمَا يُمَاثُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ. أَمَا واللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ لِي بِكُمْ أَلْفَ فَارِسٍ مِنْ بَنِي فِرَاسِ بْنِ غَنْمٍ:
«هُنَالِكَ لَودَعَوْتَ أَتَاكَ مِنْهُمْ |
فَوَارِسُ مِثْلُ أَرْمِيَةِ الْحَمِيمِ») |
(من الوافر).
قال بعض الشراح: نسبه ابن منظور في لسان العرب إلى (الهذلي) مع مغايرة بسيطة. قال: قال الهذلي:
هُنَالِكَ لَودَعَوْتَ أَتَاكَ مِنْهُمْ |
رِجَالٌ مِثْلُ أَرْمِيَةِ الْحَمِيمِ |
ووجه استشهاد الإمام (عليه السّلام) به أنّه كان يتمنّى لو أنّ لديه بدل أهل الكوفة من إذا دعوا أجابوا مسرعين، ومن إذا استغيث بهم أغاثوا؛ فقد جاء قبله: (أَمَا واللَّهِ...).
وبنو فرس بن غنم، أو فراس بن غنم: حيّ عربيّ مشهور بالشجاعة. وأرمية الحميم: سُحُب الصيف، ويضرب بها المثل لأنّها أخّف وأسرع في الانتقال (2) .
____________________
(1) النهج 1: 333، 25/ط.
(2) رسالة الإسلام 122 (عدد 7 - 8).
ووجه الخفة لأنّها لا ماء فيها، والتي فيها لا تكون إلاّ في الشتاء. يريد بذلك: أنّ فوارس بني غنم مسرعون إذا دعوا وللإغاثة إذا استغيثوا.
فلولا أن مع الإمام من يستنهِض بهم ويُستغاث لما تجرّي من أمثال معاوية لتسنّم عرش الرئاسة، ولكن قد خلا له الجوّ فطفق يصفر ويجول. وتمنّى الإمام (عليه السّلام) لفوارس بني غنم هو أحد تمنّياته وقد تمنّى استبدال كلّ عشر من أصحابه بواحد من أذناب معاوية، حيث إنّ أهل الشام يثبتون إذا دعوا وإن كان على أمر باطل. وأما أصحابه، فهم على الحق ولا ثبات لهم كما جاء في كلام له (عليه السّلام) (1) .
____________________
(1) النهج 7: 70 - 71، 96/كلام.
باب الواو
الواو مَعَ الألف
55 - وَافَقَ شَنٌّ طَبَقَة ً (1) .
برواية نصر بن مزاحم في كتاب (صفّين) في كتابه (عليه السّلام) إلى عمرو بن عاص، ولم يذكر الزيادة المثليّة الشريف الرضي (طاب ثراه). ولفظ رواية نصر:
(من عبد الله عليّ أمير المؤمنين
إلى الأبتر ابن الأبتر عمرو بن العاص بن وائل، شانئ محمّد وآل محمّد في الجاهليّة والإسلام:
سلام على من اتّبع الهدى
أمّا بعد، فَإِنَّكَ قَدْ جَعَلْتَ دِينَكَ تَبَعاً لِدُنْيَا امْرِئٍ فاسق مَهْتُوكٍ سِتْرُهُ، يَشِينُ الْكَرِيمَ بِمَجْلِسِهِ، ويُسَفِّهُ الْحَلِيمَ بِخِلْطَتِهِ، فَصَارَ قَلْبُكَ لِقَلْبِهِ تَبَعَاً، كَمَا قِيْلَ: "وَافَقَ شَنٌّ طَبَقَةً"...).
أقول:
ذكرنا (2) رواية الرضي (رحمه الله) تحت المثل: (اتِّبَاعَ الْكَلْبِ لِلضِّرْغَامِ يَلُوذُ بِمَخَالِبِهِ).
قال ابن الأثير : (هذا مثل للعرب يضرب لكلّ اثنين أو أمرين جمعتهما حالة واحدة اتّصف بهما كلّ منهما، وأصله فيما قيل: إنّ شنّاً قبيلة من عبد القيس، وطبقاً حيّ من إياد، اتفقوا على أمرٍ فقيل لهما ذلك؛ لأنّ كلّ واحد منهما وافق شكله ونظيره. وقيل: شنّ رجل من دهاة العرب، وطبقة امرأة من جنسه زُوّجت منه ولهما قصّة، وقيل: الشّن وعاء من أدم تشّنن، أي أخلِق، فجعلوا له طبقاً من فوقه فوافقه،
____________________
(1) النهج 16: 160 - 163، 39/كتاب.
(2) انظر: ص 21 من هذا الكتاب.
فتكون الهاء في الأوّل للتأنيث، وفي الثاني ضمير الشّن) (1) .
أثبت المثل جمعٌ، منهم الميداني . قال:
(قال ابن الكلبي: طبقةُ قبيلةٌ من إياد كانت لا تطاق، فوقع بها شّن بن أفصى... فانتصف منها وأصابت منه، فصار مثلاً للمتفقَيْن في الشّدة وغيرها. قال الشاعر:
لَقَيَتْ شَنُّ إيَاداً بِالْقِنَا |
طَبْقاً وَافَقَ شَنٌّ طَبَقَهْ) (2) |
____________________
(1) النهاية في (طبق).
(2) مجمع الأمثال 2: 360 حرف الواو.
الواو مَعَ التّاء
56 - وتِلْكَ شَكاةٌ ظاهِر ٌ عَنْكَ عَارُها (1) .
(من الطويل)
من قصيدة لأبي ذؤيب الهذلي يرثي بها نشيبة بن محرث الهذلي، أوّلها:
هَلِ الدَهرُ إِلاَّ لَيلَةٌ وَنَهارُها |
وَإِلّا طُلوعُ الشَمسِ ثُمَّ غِيارُها |
|
أَبى القَلبُ إِلاَّ أُمَّ عَمروٍ وَأَصبَحَت |
تُحَرَّقُ ناري بِالشَكاةِ وَنارُها |
|
وَعَيَّرَها الواشونَ أَنّي أُحِبُّها |
وَتِلكَ شَكاةُ ظاهِرٌ عَنكَ عارُها (2) |
تمثّل به الإمام (عليه السّلام) في جوابه لمعاوية:
(وزَعَمْتَ أَنِّي لِكُلِّ الْخُلَفَاءِ حَسَدْتُ! وعَلَى كُلِّهِمْ بَغَيْتُ! فَإِنْ يَكُنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَلَيْسَتِ الْجِنَايَةُ عَلَيْكَ فَيَكُونَ الْعُذْرُ إِلَيْكَ:
..................................... |
وتِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا). |
أي إن كنت حاسداً لهم وباغياً كما رعمت، فليس ذنب ذلك عليك وأنت على عذر منه. وفي نفي الجناية عن معاوية إن صدق في رمي الحسد والبغي إليه (عليه السّلام) إبطال لاستمساكه بذلك لرئاسته، وأنّه ليس بكفيل لهم ولا حقّ له ولا ولاية عليهم، أو أنّ من يطلب حقّاً ثابتاً على الآخرين ليس بجناية وإن أوهمها. وكم من مواطن فيها مطالبة الحقوق معدودة من الجناية عند قوم وليست كذلك، ولا يرتاب المطّلع على حادثة السقيفة والشورى وما نصّ الرسول (صلّى الله عليه وآله) على إقامة الإمام (عليه السّلام) مقامه من بعده يوم غدير خم: أنّ الخلافة من حقّه الثابت، فمطالبة الحقّ ليست جناية ولا حسداً ولا بغياً منه عليهم. ومن هوان
____________________
(1) النهج 15: 183، 28/ك.
(2) رسالة الإسلام 124 - 125 عدد 7 - 8.
الدنيا مخاطبة أمير المؤمنين (عليه السّلام) أمثال معاوية كما نسب إليه (عليه السّلام): (إنّ الدّهر أنزلني حتّى قيل: عليّ ومعاوية).
ولعلّ من أهمّ الغصص وأمضّها مواجهة الأنذال ومكالمتهم. ومن ذلك قول زينب بنت أمير المؤمنين (عليهما السّلام) مخاطبة ليزيد بن معاوية: (ولئن جرّت عليّ الدواهي مخاطبتك إنّي لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك...) (1) عند دخول حرم الحسين (عليه السّلام) عليه (لعنة الله).
____________________
(1) اللهوف 71.
الواو مَعَ الحاء
57 –
هَلِ الدَهرُ إِلاَّ لَيلَةٌ وَنَهارُها |
|
وَإِلّا طُلوعُ الشَمسِ ثُمَّ غِيارُها |
وَحَسبُكَ دَاءً أَن تَبيتَ بِبِطْنَةٍ = وَحَولُكَ أكبادٌ تَحِنُّ إِلى القِدِّ (1) .
من أبيات منسوبة إلى حاتم الطائي تمثّل به الإمام (عليه السّلام) في كتاب له إلى عثمان بن حنيف عامله على البصرة عندما بلغه أنّه دعى إلى مأدبة فأجاب إليها.
وفي لفظ المعتزلي بدل (وحسبك) (كفى بك عاراً أن تبيت ببطنة).
وأوّلها:
أَيا اِبنَةَ عَبدِ اللَهِ وَاِبنَةَ مالِكٍ |
وَيا اِبنَةَ ذي الجدين وَالفَرَسِ الوَردِ |
|
إِذا ما صَنَعتِ الزادِ فَاِلتَمِسي لَهُ |
أَكيلاً فَإِنّي لَستُ آكِلَهُ وَحدي |
|
قصّياً بعيداً أو قريباً فإنّني |
أخاف مذ مات الأحاديث من بعدي |
|
كفى بك عاراً دَاءً أَن تَبيتَ بِبِطْنَةٍ |
وَحَولُكَ أكبادٌ تَحِنُّ إِلى القِدِّ |
|
وَإِنّي لَعَبدُ الضَيفِ ما دامَ نازلاً |
وَما من خلالي غيرها من شيمَةِ العَبدِ (2) |
ليس أمير المؤمنين (عليه السّلام) ليحذّر الناس عن شيء وهو يأتي به ككثير من الوعّاظ والآمرين بالمعروف منهم، ويأمر بشيء ويتركه، فإذا هو يندّد عن البطنة بقوله:
(وَحَسبُكَ دَاءً أَن تَبيتَ بِبِطْنَةٍ |
وَحَولُكَ أكبادٌ تَحِنُّ إِلى القِدِّ) |
لم تكن صفته ذلك. يقول (عليه السّلام):
(أَوأَبِيتَ مِبْطَاناً وحَوْلِي بُطُونٌ غَرْثَى وأَكْبَادٌ حَرَّى؟!).
كان (عليه السّلام) يطوى الليل طوياً بالبكاء والعبادة لله تعالى وغشْيَته من خشية الله (عزّ وجلّ) في الليالي في حديقة بني النجار. وقوله (عليه السّلام): (آهِ آهِ مِنْ قِلَّةِ الزَّادِ وبُعْدِ السَّفَرِ...) معروفة. وهو
____________________
(1) النهج 16: 286، 28/ك.
(2) شرح النهج 16: 288.
القائل في نفس الخطبة المعنيّة: (وإِنَّ إِمَامَكُمْ قَدِ اكْتَفَى مِنْ دُنْيَاهُ بِطِمْرَيْهِ، ومِنْ طُعْمِهِ بِقُرْصَيْهِ) أي قرصان يفطر عليهما لا ثالث لهما. والطمر: الثوب الخلق البالي من إزار ورداء يستر بهما جسده الشريف. أيا مَنْ نصبتَ نفسك رأساً على الناس انظر إلى إمام الرؤساء! إلى لبسته وطعمته، إلى محبّته وشفقته، إلى زهده وعبادته.
الواو مَعَ الدّال
58 - وَدَعْ عَنْكَ نَهْباً صيحَ في حُجَراتِهِ (1) .
من كلام له (عليه السّلام) لبعض أصحابه وقد سأله كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم أحقّ به؟! فقال (عليه السّلام):
(يَا أَخَا بَنِي أَسَدٍ، إِنَّكَ لَقَلِقُ الْوَضِينِ، تُرْسِلُ فِي غَيْرِ سَدَدٍ. ولَكَ بَعْدُ ذِمَامَةُ الصِّهْرِ وحَقُّ الْمَسْأَلَةِ، وقَدِ اسْتَعْلَمْتَ فَاعْلَمْ:
أَمَّا الِاسْتِبْدَادُ عَلَيْنَا بِهَذَا الْمَقَامِ ونَحْنُ الأعْلَوْنَ نَسَباً والأشَدُّونَ بِالرَّسُولِ (صلَّى الله عليه وآله) نَوْطاً، فَإِنَّهَا كَانَتْ أَثَرَةً شَحَّتْ عَلَيْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ وسَخَتْ عَنْهَا نُفُوسُ آخَرِينَ والْحَكَمُ اللَّهُ والْمَعْوَدُ إِلَيْهِ الْقِيَامَةُ.
ودَعْ عَنْكَ نَهْباً صِيحَ فِي حَجَرَاتِهِ |
ولَكِنْ حَدِيثاً مَا حَدِيثُ الرَّوَاحِلِ) |
قال المعتزلي :
(وأمّا البيت، فهو لامرئ القيس بن حجر الكندي. ورُوى أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) لم يستشهد إلاّ بصدره فقط وأتمّه الرواة) (2) .
(قيل: إنّ امرئ القيس امتدح بالبيت جارية بن مرّ الثعلي بعد أن تحوّل إليه من جوار خالد بن سدوس النهباني. في حينها نهب بعض بني جديلة إبل امرئ القيس، وأراد أن يسترجعها منهم خالد وهو على رواحل امرئ القيس فنهبوها أيضاً) (3) .
أقول:
ظاهر كلامه (عليه السّلام): (ولَكَ بَعْدُ ذِمَامَةُ الصِّهْرِ) أنّ السائل من بني أسد، وكانت مصاهرة منه (عليه السّلام) معهم. فما أنكره
____________________
(1) النهج 9: 241، 163/كلام.
(2) شرح النهج 9: 243.
(3) رسالة الإسلام 124 (عدد 7 - 8).
المعتزلي - ردّاً على القطب الراوندي - في غير محلّه، فراجع (1) .
يريد (عليه السّلام) من التمثل بالبيت المذكور: أنّ نهب هؤلاء القوم لحقوقنا الثابتة كنهب الآبال مع أنّ الناهب راكب على رواحل منهوبة، وحال القوم كذلك!! قد غصبوا حقّ الخلافة وبعدها يعاملون معه (عليه السّلام) من لا حقّ له مذكور في الدهور. ولا غرو في ذلك فإنّ شأن الدّهر ذلك.
____________________
(1) شرح النهج 9: 242.
الواو مَعَ القاف
59 - وَقَدْ يَستَفيدُ الظِنَّة َ المتَنَصِّحُ (1) .
تمثّل به (عليه السّلام) في أثناء جوابه لكتاب معاوية:
(ومَا كُنْتُ لِأَعْتَذِرَ مِنْ أَنِّي كُنْتُ أَنْقِمُ عَلَيْهِ أَحْدَاثاً. فَإِنْ كَانَ الذَّنْبُ إِلَيْهِ إِرْشَادِي وهِدَايَتِي لَهُ، فَرُبَّ مَلُومٍ لا ذَنْبَ لَهُ.
..................................... |
«وقَدْ يَسْتَفِيدُ الظِّنَّةَ الْمُتَنَصِّحُ»). |
وهذه الفقرة ذكرناها عند المثل: (رُبَّ مَلُومٍ لا ذَنْبَ لَهُ) والإعادة لأجل ربط المثل الجاري، وهو من (الطويل).
قال بعض: صدره: (وكم سقتُ في آثاركم من نصيحةٍ). والظّنة: التهمة. والمتنصّح: المبالغ في النصح لمن لا ينتصَّح. وربما كان مأخوذاً من قولهم: (سقطتَ من النصيحةِ على الظَّنَّةَ) (2) ومعناها: أنّ المتنصّح قد تأتيه التهمة بسبب إخلاصه النصيحة إلى من لا ينتصح بها (3) .
أقول:
لقد قضى الناصح ما عليه من أداء رسالته، ويكون السامع مخاطباً بقوله تعالى: ( وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لاَ تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ ) (4) .
وقد جاء في "الأمثال النبويّة" : (إنّ الدّين النصيحة) بتمام معنى الكلمة. من نصح قوليّ وعمليّ للخالق (عزّ وجلّ) والخَلق وأمير المؤمنين (عليه السّلام) نصح الخلائق، سواء كانوا في زمانه أو الأزمنة المتأخّرة إلى يوم القيامة، ببلوغ كتابه الذي بعد كلام الخالق تعالى وفوق كلام المخلوق. وليس هو
____________________
( 1) النهج 15: 183، 28/ك.
(2) المستقصي 3: 119.
(3) رسالة الإسلام 125 (عدد 7 - 8).
(4) سورة الأعراف الآية 79.
إلاّ شرحاً وتفسيراً له.
ثم التعبير باستفادة الظّنة، وهي التهمة، لأجل حصولها في سبيل الله تعالى. فكلّ ما أتى المؤمن في طريق أداء الرسالة عدّ من الفوائد وإن كان بظاهره من نوع الأذى والأمر المكروه، ويتحقّق فيه قوله تعالى: ( وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ) (1) . وعليه، فلا وجه لحمله على المجاز أو التهكّم.. وقد شرحنا باقي الفقرة فيما تقدّم فراجع (2) .
____________________
(1) سورة البقرة الآية 216.
(2) تحت رقم: المثل 11، ص 45.
الواو مَعَ الياء
60 - وَيْلَ أُمِّهِ (1) .
هذه الكلمة استعملها الإمام (عليه السّلام) في كلام له (عليه السّلام) في ذمّ أهل العراق، أوّله:
(أَمَّا بَعْدُ، يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ... ولَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تَقُولُونَ عَلِيٌّ يَكْذِبُ! قَاتَلَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى!! فَعَلَى مَنْ أَكْذِبُ أَعَلَى اللَّهِ؟! فَأَنَا أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِهِ. أَمْ عَلَى نَبِيِّهِ؟! فَأَنَا أَوَّلُ مَنْ صَدَّقَهُ. كَلا واللَّهِ، لَكِنَّهَا لَهْجَةٌ غِبْتُمْ عَنْهَا ولَمْ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهَا. "وَيْلُ أُمِّهِ" كَيْلاً بِغَيْرِ ثَمَنٍ لَو كَانَ لَهُ وِعَاءٌ.. ولَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ).
إنّما أثبتنا أكثر كلامه (عليه السّلام) لربط الكلمة به.
قال المعتزلي في شرحها: (وَيْلُمِّه: الضمير راجع إلى ما دلّ عليه معنى الكلام من العلم؛ لأنّه لمّا ذكر اللهجة وشهوده إيّاها وغيبوبتهم عنها دلّ ذلك على علم له خصّه به الرسول (عليه السّلام)، فقال: (ويلمّه)، وهذه الكلمة تقال للتعجّب والاستعظام، يقال: (ويلمّه فارساً)، وتكتب موصولة كما هي بهذه الصورة، وأصله (وَيْلُ أُمِّهِ) مرادهم التعظيم والمدح وإن كان اللفظ موضوعاً لضدّ ذلك كقوله (عليه الصلاة والسلام): (فاظْفَرْ بذاتِ الدِّين ترُبَتْ يدُاك) (2) ، وكقولهم لرجل يصفونه ويفرّطونه: (لا أباً له) (3) .
جاءت كلمة (ويل أمّه) في قصّة جذيمة مع الزباء ومولاه قصير، أشرنا (4) إلى إجمالها عند المثل (لو كان يطاع لقصير أمر)، وفيها أنْ نَصَحَ قصير
____________________
(1) النهج 6: 127، 70/ك.
(2) أثبتناه في حرف التاء من الأمثال النبويّة.
(3) شرح النهج 6: 133.
(4) راجع: ص 120.
جذيمة فلقيته الخيول والكتائب فحالت بينه وبين العصا (والعصا فرس جذيمة) فركبها قصير ونظر إليه جذيمة على متن العصا مولِّياً، قال: (ويل أمّه حزماً على متن العصا) فذهبت مثلاً... (1) والقصّة طويلة اختصرناها لموضع المثل.
____________________
(1) مجمع الأمثال 1: 234 حرف الخاء.
باب الياء
الياء مَعَ الدّال
61 - يَدُ اللهِ عَلى الجَماعَةِ (1) .
من كلام له (عليه السّلام) قاله للخوارج، ومنه قوله (روحي فداه): (والْزَمُوا السَّوَادَ الأعْظَمَ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ على الْجَمَاعَةِ، وإِيَّاكُمْ والْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ كَمَا أَنَّ الشَّاذَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْبِ...).
أقول:
قد صحّ هذا المثل عن النّبي (صلّى الله عليه وآله) أيضاً بلفظ: (يد الله مع الجماعة) رواه جمع من المحدثين والأدباء من الشيعة والسنة (2) ، أي أنّ الجماعة المتّفقة من أهل الإسلام في كنف الله ووقايته فوقهم، وهم بعيدون من الأذى والخوف، فأقيموا بين ظهرانيهم. وفي حديث: (عليكم بالجماعة فإنّ يد الله على الفسطاط) (الفسطاط: المصر الجامع، ويد الله كناية عن الحفظ والدفاع عن أهل المصر، كأنّهم خصوا بوقاية الله تعالى وحسن دفاعه) (3) . والإمام (عليه السّلام) حذّر القوم من الفرقة ومثّل لهم مغّبتها بالغنم المتخلّف من الأغنام التي هي تحت رعاية الراعي، فكما هو للذئب لا محالة كذلك المتخلّف عن الجماعة للذئاب الإنسيّة والجنيّة من الشياطين. وفي حديث الإمام الرضا (عليه السّلام) قال: (إنّما جعلت الجماعة لئّلا يكون الإخلاص والتوحيد والإسلام والعبادة لله إلاّ طاهراً مكشوفاً مشهوراً؛ لأنّ في
____________________
(1) النهج 8: 112، 127/كلام.
(2) جامع الأصول 6: 564 المحاضرة والتمثيل 27.
(3) النهاية في (يد).
إظهاره حجّة على أهل الشرق والغرب لله وحده، وليكون المنافق والمستخّف مؤدّياً لما أقرّ به يظهر الإسلام والمراقبة، وليكون شهادات الناس بالإسلام بعضهم لبعض جائزة ممكنة، مع ما فيه من المساعدة على البّر والتقوى، والزجر عن كثير من معاصي الله (عزّ وجلّ)) (1) .
ومن أمر الله تعالى بالاعتصام بحبله والنهي عن التفرقة يعرف الاهتمام البالغ بهذا الصدد، كما يعلم ذلك من رواية الإحراق بالنار لدار من لم يحضر جماعة المسلمين (2) . ولا ينافي لزوم الجماعة ما جاء من النهي في أحاديث أهل البيت (عليهم السّلام) عن أن يقول الرجل: أنا أحد من الناس، وأنا مع الناس، فقد روى الصدوق عن الصادق (عليه السّلام) قوله: (ولا تكن إمَّعة) (3) . وذلك يراد به في الأمر المحرّم شرعاً وعقلاً، وهم الهمج من الناس يميلون مع كلّ ريح.
هذا آخر ما أردناه هنا.
والحمد لله تعالى أوّلاً وآخراً، وصلّى الله على محمّد وآله، لا سيَّما الإمام المهدي (عجَّل الله تعالى فرجه الشريف).
____________________
(1) الوسائل 5: 375.
(2) الوسائل 18: 289 - 290.
(3) معاني الأخبار 266.
في الختام
يعجبني ذكر خمسة أبيات وجدتها على هامش بعض نسخ النهج المطبوعة، وهي:
نهجُ البلاغةِ نهجُ العلمِ والعملِ |
فاسْلِكْهُ ياصاحِ تبلغْ غايةَ الأملِ |
|
ألفاظُه دُرَرٌ زَانَتْ بِحُلْيَتِهَا |
أهلَ الفضائلِ من حُلْيٍ ومن حُلَلِ |
|
ومن معانيهِ أنوارُ الهدى سطعتْ |
تَنْجَابُ عنها ظلامُ الزَّيغِ والزَّلَلِ |
|
وكيف لا وَهْوَ نهجٌ طابَ منْهَجَهُ |
هَدَى إليه أميرُ المؤمنينَ عليّ |
|
وما قاله المرتضى مرتضى |
كلامُ عَلِيٍّ كلامٌ عَلِيّ |
* * *
والله (عزّ وجلّ) نسأل أن يسلك بنا منهج مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده الأحد عشر المعصومين، خلفاء الرّسول الأعظم (صلّى الله تعالى عليهم وسلّم). ويجمعنا معهم في دار السلام.
1- المُحْتَوَيَاتُ
2- المَصادِرُ
الصفحة المثل الرقم
27 أَمَرْتُكُمْ أَمْرِي بِمُنْعَرَجِ اللِّوَى 5
29 أَيَادِيَ سَبَأ 6
31 ومَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ 7
33 باب الباء
35 بَعْدَ اللَّتَيَّا والَّتِي 8
37 باب التاء
39 تَقْصُرُ دُونَهَا الأنُوقُ ويُحَاذَى بِهَا الْعَيُّوقُ 9
41 باب الحاء
43 حَدْو الزَّاجِرِ بِشَوْلِهِ 10
45 الْحَسَدَ يَأْكُلُ الإيمَانَ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ 11
47 الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ 12
49 حَنَّ قِدْحٌ لَيْسَ مِنْهَا 13
51 باب الدال
53 دَعْ عَنْكَ مَنْ مَالَتْ بِهِ الرَّمِيَّةُ 14
55 الدَّهْرَ يَوْمَانِ يَوْمٌ لَكَ ويَوْمٌ عَلَيْكَ 15
57 باب الراء
59 رُبَّ قَوْلٍ أَنْفَذُ مِنْ صَوْلٍ 16
60 رُبَّ مَلُومٍ لا ذَنْبَ لَهُ 17
62 رُدُّوا الْحَجَرَ مِنْ حَيْثُ جَاءَ 18
64 الرَّفِيقِ قَبْلَ الطَّرِيقِ والْجَارِ قَبْلَ الدَّارِ 19
66 رَكِبْنَا أَعْجَازَ الآبِلِ 20
الصفحة المثل الرقم
68 باب السين
69 سُرُوحُ عَاهَةٍ بِوَادٍ وَعْثٍ 21
71 باب الشين
73 شَتَّانَ مَا يَوْمِي عَلَى كُورِهَا 22
75 الشَّرُ بالشَّرِ مُلْحَق 23
77 شِقْشِقَةٌ هَدَرَتْ ثُمَّ قَرَّتْ 24
79 باب الصاد
81 صَاحِبُ السُّلْطَانِ كَرَاكِبِ الأسَدِ 25
83 باب الضاد
85 ضَحِّ رُوَيْداً 26
87 باب العين
89 عِنْدَ الصَّبَاحِ يَحْمَدُ الْقَوْمُ السُّرَى 27
91 باب الفاء
93 فَاعِلُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنْهُ وفَاعِلُ الشَّرِّ شَرٌّ مِنْهُ 28
95 باب القاف
97 قَدْ أَضَاءَ الصُّبْحُ لِذِي عَيْنَيْنِِ 29
99 باب الكاف
101 كَلَعْقَةِ لاعِقٍ 30
103 كَمَا تَدِينُ تُدَانُ 31
105 كَمْ مِنْ أَكْلَةٍ مَنَعَتْ أَكَلاتٍ 32
107 كَنَاقِشِ الشَّوْكَةِ بِالشَّوْكَةِ 33
109 كَنَاقِلِ التَّمْرِ إِلَى هَجَرَ 34
الصفحة المثل الرقم
111 باب اللام
113 لا رَأْيَ لِمَنْ لا يُطَاعُ 35
115 لَبِّثْ قَلِيلاً يَلْحَقِ الْهَيْجَا حَمَلْ 36
117 لَجَمَلُ أَهْلِكَ وشِسْعُ نَعْلِكَ خَيْرٌ مِنْكَ 37
119 لَعَمْرُ أَبِيكَ الْخَيْرِ يَا عَمْرُو إِنَّنِي 38
120 لَو يُطَاعُ لِقَصِيرٍ أَمْرٌ 39
122 باب الميم
123 مَا عَدَا مِمَّا بَدَا 40
125 الْمُتَعَلِّقُ بِهَا كَالْوَاغِلِ الْمُدَفَّعِ والنَّوْطِ الْمُذَبْذَبِ 42
127 مَثَلَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَثَلِ نُجُومِ السَّمَاءِ 42
129 مَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ الْحَيَّةِ 43
131 مَثَلُ مَنْ خَبَرَ الدُّنْيَا كَمَثَلِ قَوْمٍ سَفْرٍ 44
133 الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ ولَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ 45
135 الْمَرْأَةُ عَقْرَبٌ حُلْوَةُ اللَّسْبَةِ 46
136 مُسْتَقْبِلِينَ رِيَاحَ الصَّيْفِ تَضْرِبُهُمْ 47
138 مَنْ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوَاضِحَ وَرَدَ الْمَاءَ 48
140 مَنْ لانَ عُودُهُ كَثُفَتْ أَغْصَانُهُ 49
142 مَنْ مَلَكَ اسْتَأْثَرَ 50
144 مَنْهُومَانِ لا يَشْبَعَانِ: طَالِبُ عِلْمٍ وطَالِبُ دُنْيَا 51
146 مَنْ وَثِقَ بِمَاءٍ لَمْ يَظْمَأْ 52
الصفحة المثل الرقم
149 الْمَنِيَّةُ ولا الدَّنِيَّةُ 53
151 باب الهاء
153 هُنَالِكَ لَودَعَوْتَ أَتَاكَ مِنْهُمْ ==== فَوَارِسُ مِثْلُ أَرْمِيَةِ الْحَمِيمِ 54
155 باب الواو
157 وَافَقَ شَنٌّ طَبَقَةَ 55
159 وتِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا 56
161 وحَسْبُكَ دَاءً أَنْ تَبِيتَ بِبِطْنَةٍ 57
163 ودَعْ عَنْكَ نَهْباً صِيحَ فِي حَجَرَاتِهِ 58
165 وقَدْ يَسْتَفِيدُ الظِّنَّةَ الْمُتَنَصِّحُ 59
167 وَيْلُ أُمِّهِ 60
169 باب الياء
171 يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ 61
173 في الختام
2 - المصادر
الاحتجاج تعليق: السيد محمد باقر الخرسان، مطبعة النعمان - النجف 1386هـ.
أصول الكافي ، تعليق: علي أكبر الغفاري، چابخانه حيدري، طهران 1381هـ.
أمالي الشيخ الصدوق ، تقديم: السيد الخرسان، المطبعة الحيدريّة، النجف 1389هـ.
الأمثال النّبوية تحت الطبع ومخطوط بقلمي.
البرهان في تفسير القرآن ، طبعة (آفتاب)، طهران، 1334 شمسي.
تفسير الصافي ، المطبعة الإسلاميّة، طهران، 1384هـ.
الجمهرة على هامش مجمع الأمثال ، المطبعة الخيريّة، مصر، 1310هـ.
حياة الإمام الحسين (عليه السّلام) ، منشورات الداوري، قم - إيران، الطبعة الثانية، 1397هـ.
رسالة الإسلام ، (عدد 7 - 8)، الأزهر، 1388- 1968م.
سفينة البحار ، مطبعة سنائي طهران بالأوفست.
عيون الأخبار ، ابن قتيبة، طبعة دار الكتب المؤسّسة المصريّة، 1383هـ.
الفاخر ، تحقيق: عبد العليم الطحاوي، منشورات دار إحياء الكتب العربيّة، 1380هـ.
القرآن الكريم.
اللهوف في قتلى الطفوف ، مكتبة الأندلس، بيروت.
مجمع الأمثال ، مطبعة السعادة، مصر، 1379هـ.
مجمع البحرين ، تحقيق: أحمد علي الحسيني، مطبعة الآداب، النجف.
مجموعة ورّام ، المطبعة الحيدريّة، النجف، الطبعة الثالثة، 1389هـ.
المستقصي في أمثال العرب ، منشورات دار الكتب العربيّة، بيروت.
مسند أحمد طباعة، دار صادر، بيروت.
مصابيح الأنوار في حلّ مشكلات الأخبار ، انتشارات مكتبة بصيرتي، قم - إيران.
مفاتيح الجنان في الأدعية والزيارات ، المطبعة الإسلاميّة، طهران، 1381هـ.
الميزان في تفسير القرآن ، المطبعة التجاريّة، بيروت.
نهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، دار إحياء الكتب العربيّة، بيروت، 1383هـ.
شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربيّة، عيسى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة الثانية، 1385هـ.
وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ، الحر العاملي، المطبعة الإسلاميّة، طهران، 1383هـ.
الفهرس
الأمثالُ 4
أمثالٌ قرآنيّةٌ: 5
الأمثال السائرة، وغير السائرة 17
باب الهمزة: 17
باب الباء 33
باب التاء 37
باب الحاء 41
باب الدال 51
باب الراء 57
باب السين 68
باب الشين 71
باب الصاد 79
باب الضاد 83
باب العين 87
باب الفاء 91
باب القاف 95
باب الكاف 99
باب اللاَّم 111
باب الميم 122
باب الهاء 151
باب الواو 155
باب الياء 171
في الختام 173