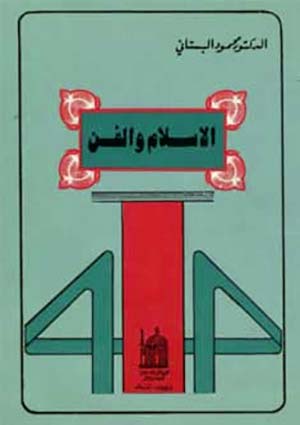الإسلام والفن
الدكتور محمود البستاني
هذا الكتاب
طبع ونشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف
شبكة الإمامين الحسنينعليهماالسلام للتراث والفكر الإسلامي
وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً
قسم اللجنة العلمية في الشبكة
الإسلامُ والفَن
الدكتور محمود البستاني
جميع حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأُولى
١٤١٣ه- - ١٩٩٢م
العنوان: بناية كليوباترا - شارع دكّاش - حارة حريك - بيروت - لبنان
( كلمةُ المَجمع )
بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيمِ
المقدمة:
في هذا الكتاب( الإسلام والفن ) تُطرح قضية الأدب والفن من خلال وجهة النظر الإسلامية مقارنةً بوجهة النظر الأرضية، في مختلف الظواهر المرتبطة بمفهوم الأدب وعناصره، وتياراته ومناهج دراسته. مضافاً إلى الظواهر المرتبطة بالأشكال الفنية الأخرى، مثل: النحت والتصوير والموسيقى، وغير ذلك من أنماط التعبير الفنّي، الذي يمتلك الإسلام حيالها تصوّراً خاصاً يختلف عن تصوّرات الأرض، من حيث: حظره أو تحفّظه أو إباحته لهذا الشكل أو ذاك...
واستكمالاً لرصد التصوّر الإسلامي للأدب والفن، حاولَ هذا الكتاب أن يُقدّم دراسة تطبيقية تتناول نصوص القرآن والسنّة، بحيث يمكن للقارئ أن يستخلص من ذلك المعايير والمبادئ التي عرض لها هذا الكتاب. عِلماً بأنّ(مَجمع البحوث الإسلامية) يعتزم تقديم دراسات أخرى تتناول بنحو مفصّل تلكم المبادئ والمعايير التي تنتظم في حقول البلاغة والنقد وتأريخ الأدب، بحيث تُعدّ دراساتٍ مفصّلة لِما أجمله كتاب( الإسلام والفن ) ، آملين من الله تعالى أن يوفّقنا جميعاً لخدمة الإسلام العظيم.
مَجمعُ البحوث الإسلامية
ما هو الفنّ ؟
الفنّ - في التجربة البشرية -: نمطٌ خاص من التعبير عن حقائق الحياة. فإذا كانت اللغة العلمية أو العادية التي نستخدمها في حياتنا اليومية تتميّز بكونها تعبيراً مباشراً عن الحقائق، فإنّ اللغة الفنية تتميّز بكونها تعبيراً غير مباشر عنها.
والفارق بين اللغة المباشرة وغير المباشرة: أنّ الأُولى منهما تعتمد نقل الحقائق بصورتها الواقعية، كما لو قلنا: إنّ (١+٣ =٤)، أو قلنا: إنّ الماء يتكوّن من عنصرين. بينما تعتمد لغة الفن عنصر ( التخيّل ) أساساً لها، أي العنصر المتمثل في إحداث ( علاقة ) جديدة بين الحقائق التي تستهدف نقلها إلى الآخرين.
فإذا أردنا أن نتبيّن - على سبيل المثال - أهمية الإنفاق ( في سبيل الله )، قلنا: إنّ مَن يُنفق أمواله من أجل الله فسيُعوّض بأضعاف ذلك، وحينئذٍ يكون هذا التعبير ( واقعياً )، أو ( عادياً )، أو ( علمياً )، لكن عندما نقول مع الآية الكريمة:( مَثَلُ الّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبّةٍ... ) حينئذٍ يكون هذا التعبير ( فنياً ). والفارق بين التعبير الأسبق وهذا التعبير، هو: إضافة أو إحداث علاقة جديدة بين ( الإنفاق ) و( الحبّة ) التي لا علاقة لها بذلك في الواقع الحسّي، والمسوّغُ لإحداث هذه العلاقة بينهما هو: تعميق الهدف أو الدلالة في ذهن المتلقّي ( القارئ، المستمع، المُشاهِد ).
ومن البيّن: أنّ بعض المواقف تستدعي أمثلة هذا التعبير بُغية تحقيق الهدف المتقدّم، بينما لا تستدعي المواقف الأخرى أمثلة ذلك، كما لو أردنا تعريف الماء مثلاً أو أيّة حقيقة علمية أو عادية.
طبيعياً أنّ ( العلم ) قد يحتاج إلى عنصر ( التخيّل ) في تعميق دلالاته أيضاً، كما لو أردنا أن نوضّح للقارئ أو نُقرّب إلى ذهنه - مثلاً - مدى احتياج الإنسان إلى الغذاء لمواصلة حياته، حيث نقوم بعملية ( تشبيه ) بينه وبين الماكنة المستخدَمة في وسيلة النقل من حيث احتياجها إلى ( الوقود )... بل إنّ ( العلم ) قد يَستخدم لغة ( التخيّل ) أساساً لبعض قضاياه، كما يُلحظ ذلك مثلاً في الجهاز المسمّى ب-( العقل الإلكتروني ) . فهذه التسمية نفسها ( فنٌ ) مادامت قد استخدَمت عنصر ( التخيّل )، إلاّ أنّ الفارق بين ( الفن ) و( العلم ) - أو ( اللغة العادية ) - يكمُن في ضخامة وضآلة النسبة التخيّلية من جانب، وفي ركون أولهما إلى عنصر ( ذاتي )، والآخر إلى عنصر ( موضوعي ) من جانب
آخر، فتشبيهنا البطل مثلاً بأنّه: ( صقر )، أو ( أسد )، يقوم على عنصر ( ذاتي )، أو ( عاطفي )، أو ( وجداني )، بينا يقوم تشبيهنا لغذاء الإنسان بوقود السيارة على عنصر ( موضوعي ) لا مجال فيه لتدخّل انفعالاتنا.
أخيراً، ينبغي لفت الانتباه على أنّ لغة الفن لا تنحصر في التعبير اللفظي الذي يعتمد الكلمة ( المنطوقة ) أو ( المكتوبة ) أداة له، بل تجاوز ذلك إلى أنماط تعبيرية أخرى تُعد بمثابة ( رمز ) للكلمة أو ( بديل ) لها، كما هو الأمر بالنسبة إلى فنون مختلفة من نحو: الرسم، والنحت، وسواهما...
والمهمّ : أنّ لغة ( الفن ) - بكلّ أشكالها - ذات سمة تعبيرية خاصة بها، كما أنّ لها مسوّغاتها المشار إليها، ومن ثَمّ دراسة هذه اللغة تظلّ من الضرورة بمكان كبير، مادمنا نعرف بوضوح أنّ ( الكلمة )، أو ( الرموز ) البديلة لها، ينبغي أن ( توظّف ) أساساً من أجل تحقيق المهمة العبادية التي أوكلتها السماء إلينا...
لكن بما أنّ التجربة البشرية ( في حقل لغة الفن ) قد اقترنت بمفارقات متنوّعة، شأنها في ذلك مثل سائر أنماط السلوك المنحرف الذي يصدر الكائن الآدمي عنه، حينئذٍ يتعيّن على الباحث تقديم وجهة النظر الإسلامية في هذا الميدان، من حيث التعريف بالمادّة الفنية وعناصرها، وما يتصل بها من مشكلات متنوّعة يثيرها المعنّيون بشئون الفنّ، وهو ما نحاول التوفّر عليه في هذه الدراسة.
الفنّ والالتزام
ما دام ( الفنّ ) يوظَّف أساساً من أجل تحقيق المهمة العبادية، حينئذٍ يتعيّن على الباحث الإسلامي تحديد معالم ( التوظيف ) المذكور، وهو ما يطلق عليه أدباء الأرض مصطلح( الالتزام ) .
إنّ ظاهرة ( الالتزام ) في التصوّر الأرضي ( ونقصد به: التصوّر غير الإسلامي ) تمتد بجذورها إلى العصر الإغريقي، مروراً بالعصر الوسيط فالعصر الحديث، وتبلورها بخاصة في سنواتنا المعاصرة عبر ربط الفن بالموقف الفلسفي العام من الكون والمجتمع والفرد...
بَيْدَ أنّ اتجاهات أرضية متنوّعة لا تُعنى بقضية ( الالتزام ) بقدر ما تعنى بالفن من حيث كونه يحقّق ( إمتاعاً ) جمالياً فحسب، بغضّ النظر عن محتوياته الفكرية، وهو أمر قد اقتادَ الباحثين منذ القديم إلى طرح السؤال التقليدي الذي قد ابتذله الاستخدام، ونعني به السؤال القائل:( هل الفن للحياة، أم الفن للفن ؟ ) .
في تصوّرنا أنّ طرح مثل هذا السؤال خاطئ أساساً ؛ فليس من المعقول - مثلاً - أن يختلف اثنان في أنّ الحياة موظّفة للإنسان، يستثمرها لإشباع حاجاته المختلفة، سواء أكان ذلك ( فنّاً ) أم ( سلاحاً نارياً ) في ساحة المعركة... من هنا، فإنّ الفنّ المعاصر تجاوزَ طرح مثل هذا السؤال ؛ لمفروضيته في الذهن.
بَيْدَ أنّ الاختلاف في وجهات النظر ( ونقصد بذلك:الاتجاهات غير الإسلامية ) تبدأ من صعيد آخر، هو: تحديد نمط ( الوظيفة ) التي يضطلع ( الفن ) بها، ومن ثَمّ تحديد نمط ( الإشباع ) للحاجات. فهناك من الباحثين مَن يعالج الظاهرة من خلال المعيار الاجتماعي والفردي، فإذا تناولَ الشاعر أو القاص، مشكلة اقتصادية أو سياسية مثلاً، أو أيّة مشكلة تتصل بالهموم العامة للإنسان، يكون ( الفن ) حينئذٍ منتسباً ل- ( الحياة ). أمّا إذا عولِجت من الزاوية الفردية التي تحوم على هموم ( الذات )، يكون ( الفنّ ) حينئذ منتسباً ل- ( الفن ) وليس للحياة.
وهناك من الباحثين مَن يعالج الظاهرة من صعيد آخر، هو:الحاجات الأوَّليَّة والحاجات الثانوية. فإذا عالجَ القاص أو المسرحي أو الشاعر، قضية ذات صلة بحاجات الإنسان الرئيسة، مثل: مشكلة الجوع أو المرض، أو أيّة حاجة لا مناص من إشباعها، كان الفن حينئذٍ منتسباً ل- ( الحياة ). أمّا
إذا تناولها من زاوية الحاجات الثانوية، مثل: الحاجة إلى الجمال ( كما لو تناولَ مشاهد الطبيعة )، كان الفن حينئذٍ منتسباً إلى ( الفن )...
وهناك اتجاه أرضي ثالث لا يصطنع أمثلة هذه الفوارق بين الحاجات الرئيسية والثانوية أو الاجتماعية والفردية، بل يجد أنّ ما يُصطلح عليه بالحاجة الفردية والثانوية، ينبغي أن ( تُشبع ) أيضاً مادامت تُمثّل ( حاجة ) من جانب، أو ما دامت هذه الحاجة تتخذ طابع ( الضرورة ) من جانب آخر، بخاصة أنّ شدائد الحياة تتطلب ( محطّات ) للترويح يتوقّف الإنسان عندها قليلاً لمواصلة نشاطه في الحياة...
وهناك اتجاه أرضي رابع لا يملك كلمة حاسمة في تحديد الموقف، حيث يجد صعوبة في التمييز بين مستويات الحاجة ؛ نظراً لتفاوت الشعوب والأجناس والأزمنة في تحديد ذلك...
وأيّاً كان الأمر، لا يَعيننا من التصوّرات الأرضية المذكورة إلاّ كونها قد انتبهت على أهمية ( توظيف الفن )، وهو أمر يتوافق مع الاتجاه الإسلامي في عملية ( التوظيف ) أو ( الالتزام )، إلاّ أنّ الفارق بين الاتجاهين ( الإسلامي والأرضي ) يبدأ من تحديد نمط ( الالتزام )، أو الخلفية الفكرية التي يرتكن إليها...
إنّ الأرضيين ( وهم في عزلة عن السماء ) لا يعونَ من الحياة إلاّ كونها مساحة محدّدة من العمر، لا ينبغي أن توظّف من أجل إشباع الحاجات العابرة للإنسان...
أمّا لماذا وجِد الكائن الآدمي، وما هي مهمته من الحياة، وما صلة ذلك بالمبدع، وباليوم الآخر... فأمر يجهله أدباء الأرض تماماً ؛ ممّا يضطرّهم إلى الصدور عن أمثلة الاتجاهات المشار إليها. ولعلّ أقصى وعي يمكن أن يحمله أمثال هؤلاء ( الملتزمين )، المنعزلين عن السماء، هو: أن ( يوظّف ) الفن من أجل الجماهير. إلاّ أنّ مثل هذا ( الالتزام ) المرتكن إلى خلفيات فلسفية منعزلة عن السماء، لا يمكن أن تُحقق هدفها الإنساني مادامت أساساً لا تملك وعياً بحقيقة الإنسان والمهمة العبادية التي خُلق من أجلها...
* * *
ومهما يكن، فإنّ الاتجاه الأرضي الملتزم بقضية الإنسان، إذا كان محكوماً بالمفارقة التي أشرنا إليها، فإنّ الاتجاهات غير الملتزمة تظل محكومة بمفارقات أكبر حجماً، بل إنّها تنحدر بقضايا الإنسان إلى أحطّ مستوياته، وهو ما يمكن ملاحظته في الاتجاه الذاهب إلى أنّ أهمية الفن تكمن في الصدق العاطفي الذي يصدر الفنان عنه، بغضّ النظر عن العنصر ( الأخلاقي ) الذي يتوافق أو يتنافر مع الصدق المذكور. فالمفروض في الفنان - في تصوّر هذا الاتجاه - أن يعبّر عن عاطفته بصدق وحرارة، حتى لو كانت هذه العاطفة نابعة من حاجات غير مشروعة.
والتسويغ الذي يُقدّمه هذا الاتجاه، قائم على جملة من التصوّرات لا تقرّها حتى الاتجاهات الأرضية الأخرى، فضلاً عن الاتجاه الإسلامي الذي يمتلك تصوّراً خاصاً حيال حاجات الإنسان وطرائق إشباعها.
من جملة المسوّغات التي يقدّمها الاتجاه الأرضي المذكور، هو:( نسبية ) القِيَم في مجتمعات الإنسان ، حيث تتفاوت هذه القيَم من مجتمع لآخر ؛ ممّا يصبح من غير المقبول مطالبة الفنان باصطناع موقف أخلاقي خاصّ، مادام كل مجتمع أو فرد له وجهة نظر معيّنة من الحياة، حيث إنّ اصطناع موقف خاص سوف يُعرّض الفنان لخسارة كبيرة، هي خسارة لقطّاع كبير من القرّاء الذين لا يتساوقون مع وجهة نظره في الحياة.
إسلامياً ( وحتى أرضياً ) لا يمكن إقرار مثل هذا المسوّغ الذي يقدّمه الاتجاه الفنّي المذكور... إنّ المتلقّي ( قارئاً، أم مستمعاً، أم مُشاهداً ) لا يكتسب قيمته عند السماء بمجرّد كونه ( متلقِّياً ) يبحث عن إشباع رغباته، بل إنّ قيمته تُحدّد بقدر إفادته من مبادئ السماء التي رسمتها له.
بكلمة جديدة : إنّ الالتزام الإسلامي في الفنّ لا يُعنى ب- ( الكم ) بقدر ما يُعنى ب- ( الكيف )، بمعنى أنّه لا يبحث عن الربح والخسارة في ( كم ) القرّاء، بقدر ما يُعنى بصياغة ( كيْفيَّتهم ) إسلامياً... ولعلّ إشارات النصوص القرآنية الكريمة إلى كون أكثر الناس: ( لا يعقلون )، ( لا يفقهون )، ( لا يعلمون )... إلخ، يُفسّر لنا هذا الجانب من الحقيقة.
طبيعياً لا يعني هذا أنّ الكاتب ينبغي أن يزهد بالمتلقّي بقدر ما يعني أنّ وظيفته تتحدّد وفقاً لمبادئ السماء، التي ينبغي أن يصدر عنها في عمله الفنّي.
إنّ عمله الفنّي ينتظمه بُعدان:
البُعد الأول : هو أن يُعنى الفنان بقارئه عناية بالغة، من خلال المهارة التي يتطلّبها العمل الفنّي، مراعياً بذلك طرائق الصياغة الفنية التي تحقّق عنصر ( الإثارة ) في القارئ.
أمّا البُعد الآخر: فيترتّب على نمط الاستجابة عند القارئ من حيث بنائه النفسي، وهو بناء قد تطبعه سمة ( السواء )، بحيث يستجيب للأفكار المطروحة في النص. وقد تطبعه سمة ( المرض ) أو ( الشذوذ )، فينسلخ عنها منصاعاً لرغباته الشاذّة...
ومن الطبيعي حينئذٍ ألاّ يُعنى الفنان بأمثلة هذا المتلقّي الأخير ؛ مادام أساساً يصدر عن استجابة منحرفة، وهو أمر قد شدّد عليه القرآن الكريم حينما رسمه مبدأ عاماً في عملية التوصيل، سواء أكان هذا التوصيل علمياً أم فنياً، حيث خاطبَ النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومطلق المضطلعين بتوصيل رسالة السماء، بقوله تعالى:( إِنّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ) ،( وَمَا أَكْثَرُ النّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ) ،( فَلَعَلّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِم إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً ) ... إلخ، حيث تصح هذه النصوص وسواها عن وجهة النظر الإسلامية حيال المتلقّي وإسقاطه من الحساب...
والحقّ : أنّ العناية بالمتلقّي ومحاولة كسبه - في ضوء الاتجاه الأرضي المذكور - يظلّ أمراً غير عملي في ميدان التطبيق ؛ إذ إنّ الفنان سوف يحصر نشاطه في ظواهر محدودة تشترك الإنسانية فيها جميعاً، ممّا يُقلّص من دائرة ( الكم ) الذي يُعنى به، وهو أمر يتنافى أساساً مع المسوّغ الذي يقدّمه في هذا الصدد. هذا فضلاً عن أنّ أصحاب هذا الاتجاه لم يلتزموا عملياً بمبادئهم، حيث نجدهم يتناولون
ظواهر مختلفة تتسم بطابع ( النسبية ) التي يرفضونها.
ولعلّ الاتجاه الأشدّ خطورة ضمن هذا المذهب الرافض للالتزام، هو: الاتجاه الذاهب إلى أنّ ( الصدق العاطفي ) يفرض على الفنان معالجة الظواهر حتى لو كانت غير مقبولة اجتماعياً، أي أنّه على العكس تماماً من الاتجاه القائل بنسبية الأخلاق فيما انتهينا توّاً من الإشارة إليه. إنّه اتجاه ذاهب إلى أنّ وظيفة الفنان تفرض عليه معالجة الجانب السلبي من السلوك، ليس بهدف تعديله، بل بصفته ( واقعاً ) لا مناص من الصدور عنه.
وقد نشطَ هذا الاتجاه منذ القرن الماضي على يد بعض القَصَصِيين والنقّاد في زحمة اكتشاف بعض الحقائق البيولوجية في حياة الإنسان، كما تبلورَ بوضوح في القرن الحالي بعد ظهور مدرسة التحليل النفسي، وتأكيد بعض أصحابها على الحياة اللاشعورية للإنسان، والمبالغة في إكسابها مدى كبيراً من الخطورة، بخاصة الميول الجنسية والعدوانية.
إنّ المفارقة التي ينطوي عليها هذا الاتجاه تكمن في تسويغه للحظات الضعف أو الخطأ الذي يصدر الإنسان عنه، فالسرقة مثلاً، أو العمل الجنسي غير المشروع، أو العربدة... إلخ، تظلّ - في تصوّر هذا الاتجاه - عملاً مشروعاً ما دام البناء النفسي للشخصية محكوماً بالطابع الفطري أو البيئي لها، ومن ثمّ فإنّ تسجيلها في عمل فنّي وتسويغها يكسب العمل المذكور طابع النجاح الفنّي لها.
ومهما يكن، فإنّ هدفنا من هذا العرض العابر للاتجاهات الأرضية بنمَطيها الملتزم وغير الملتزم: أن يخلص إلى تحديد معالم الالتزام الإسلامي وافتراقه من التصوّرات الأرضية، وهي تصوّرات لاحظنا مدى خبطها في تحديد وظيفة الفن، ثمّ انشطارها إلى تيار ( ملتزم ) ترفده خلفية فلسفية منعزلة عن السماء، وتيّار لا يُعنى بالفن إلاّ من خلال كونه وسيلة لإشباع الحس الجمالي الصرف عند الإنسان، حيث يكتسب العمل الفنّي قيمته من خلال البناء العماري للقصيدة أو المسرحية مثلاً، ومن خلال العنصر الصوري فيها، ومن خلال عنصر الإيقاع.... فهذه الجزئيات أو العناصر عندما تنتظم في شكل فنّي، تصبح هيكلاً هندسياً يبعث الإثارة عند المتلقّي، ويشبع حاجته إلى الإحساس بالجمال، يستوي في ذلك أن تكون الأفكار ( خيّرة أم شريرة ) في الشكل الفنّي المذكور.
طبيعياً أنّ هذه الاتجاهات بنمَطيها، لا تتوافق مع التصّور الإسلامي الذي ينطلق في ممارسته للفن من مفهوم عبادي خاص، هو: أنّ الإشباع الجمالي الصِّرف لا قيمة له ألبتة ما لم يقترن بهدف، كما أنّ الالتزام بهدف ينبغي أن يتحدّد وفق مبادئ الإسلام. وهذا يعني أنّ قضية ( الالتزام ) في الفن أمر مفروض منه، وأنّ السؤال الأرضي القائل بأنّ: ( هل الفن للحياة أم للفن ؟ )، لا معنى له في التصوّر الإسلامي ؛ مادام الفنّ ( وسائر أنماط الممارسات ) موظّفة من أجل تحقيق المهمة العبادية في الأرض.
إنّ ما ينبغي أن نقرّره بحسمٍ هو: ليس السؤال عن ( توظيف ) الفن، بل ينبغي استبداله بسؤال
آخر هو:
ما هي إمكانات ( الفن ) في تحقيق المهمة العبادية التي خلقتنا السماء من أجلها ؟ هل يمتلك ( الفن ) قدرات توصيلية ذات بال، بحيث يحقّق تأثيره المطلوب في الأعماق ؟ وما هي نسبة ذلك ؟
إنّه من الممكن أن يُقلّل البعض من أهمية الفن حتى يصل الأمر إلى تجاهله تماماً، كما قد يبالغ في إكسابه أهمية كبيرة حتى أنّه ليغامر بالقول إلى: أنّ الفن يستطيع أن يغيّر وجه التاريخ مثلاً.
إنّ كلاً من النظرتين:( إهمال الفن، أو المبالغة في أهميته ) ، قد يشكلان تفريطاً وإفراطاً إذا أخذناهما في نطاق الحياة العامة، لكنّهما قد يتّسمان بالصواب في ظل بعض الشروط الخاضعة لنسبية الزمان والمكان والجنس ونحو ذلك. بَيْدَ أنّ القول بأنّ ل-( الفن ) أهميته الخاصة - كما أشرنا إلى ذلك في الحقل الأول - في تعميق الهدف أو الدلالة التي نستهدف توصيلها إلى الآخرين... مثل هذا القول يظلّ صائباً دون أدنى شك، إلاّ أنّ أول ما ينبغي طرحه ( في الإجابة على أهمية الفنّ ) هو: هل أنّ الفن إنّما اكتسبَ أهميته لمجرّد كونه يعبّر ( بصدق ) عن الحقائق الإسلامية مثلاً، أم لكونه يعبّر عن الحقائق المذكورة وفق لغة خاصة متميزة عن الكلام العلمي أو العادي ؟
لا شك أنّ مجرّد كون الفن ( ومنه الشِعر مثلاً ) قد عبّر عن الحقائق الإسلامية ب- ( صدق )، هذا وحده كافٍ في تثمين القصيدة، إلاّ أنّ القصيدة ( في هذه الحالة ) لا تختلف عن أيّ كلام عادي آخر له تأثيره في كسب الجمهور إلى الصف الإسلامي: كما لو هتفَ متظاهر بسقوط الطغاة، أو كتبَ شعار على الجدران، أو كُتبت مقالة افتتاحية في إحدى الصحف.
فالهتاف والشعار وافتتاحية الصحيفة، لا تنطوي على أيّة خصائص فنية، بل إنّها مجرّد تعبير عن واقعة، أو موقف، أو حقيقة من حقائق الحياة. والأمر نفسه فيما يتصل بالقصيدة التي تعبّر عن القضية الإسلامية من دون أن تتوفّر فيها خصائص الفن، على نحو ما نلحظه مثلاً في ألفيّة ابن مالك، ومنظومات ( السبزواري ) و( الأعسم ) وغيرهم، ممّن شرحوا بعض الحقائق المتصلة بعلوم النحو والفلسفة وآداب المائدة.
ففي هذه ( المنظومات ) تقرير لحقائق لا تملك من الفن إلاّ فضيلة الوزن والقافية، إذ إنّ هدف الشخصيات المذكورة هو: تيسير حفظ هذه الحقائق ؛ لسببٍ واضح هو: أنّ الشِعر أيسر حفظاً من النثر، وإلاّ فإنّهم يعرفون قبل غيرهم أنّ خصائص فن الشعر غائبة تماماً عن منظوماتهم، بل إنّهم أساساً لا يعنيهم أيّ طابع فنّي بقدر ما يعنيهم أن يُيسّروا إيصال الحقائق إلى ذاكرة الحفّاظ.
إنّ إدراك مثل هذه الحقائق يدلّنا على أنّ القصيدة الخالية من خصائص الفن، لا علاقة لها بوظيفة الشعر ( من حيث كونه فنّاً )، بل إنّها تعبير عادي عن القضية الإسلامية، وحينئذٍ فإنّ تثمينها يقوم ( ليس على أنّها فنّ )، بل على أنّها مجرّد كلام لا يختلف عن الهتاف والشعار والمقالة الافتتاحية والمنظومة العلمية، طالما تفتقد جميعاً أهم عناصر الفن الذي أشرنا إلى أنّ ( التخيّل العاطفي ) هو
المجسّد لحقيقته في المقام الأول.
وفي مثل هذه الحالة لا يحقّ لنا أن نقول: إنّ للفن أهميته العظيمة في التعبير عن القضية الإسلامية، لا يحقّ لنا أن نسوق أمثلة هذا الحكم ؛ نظراً لعدم وجود ( الفن ) في هذه القصيدة حتى يمكن أن يقال عنها ( إنّها حقّقت أهمية )، بل إنّ أهميتها تنحصر في كونها قد عبّرت بصدق عن القضية الإسلامية.
وحينئذ نتساءل: ما هو المسوّغ لأن يُرهق الشاعر أعصابه في صياغة الوزن والقافية، حيث كان بمقدوره أن يصوغ الحقائق بحرّية كاملة من خلال النثر، دون أن يتقيّد بحواجز الوزن والقافية ؟
مع ذلك، لا يحقّ لنا أن نمنع مثل هذا الشاعر ( ونحن نطلق هذا الاسم عليه تجوّزاً ) من كتابة القصيدة المذكورة، كل ما في الأمر لا نطلق على ما كتبه مصطلح ( القصيدة )، بل نطلق على ذلك مصطلح ( المنظومة )، كما لا نطلق على كتابته مصطلح ( الفن )، ومن ثمّ لا نقول: إنّ الفن قد حقّق وظيفته الإسلامية ؛ لأنّنا لم نواجه ( فنّاً )، بل كلاماً عادياً.
من هنا، فإنّ تحديد وجهة نظر إسلامية خاصة حول الفن، لا يمكن أن ندرجها في نطاق تأمين مثل هذه القصائد، بل إذا أردنا أن نُحدّد تصوّراً إسلامياً خاصاً حيال الفن، حينئذٍ ينبغي أن نتّجه إلى الأشكال التي تحمل خصائص الفن فعلاً، وهو أمر يمكننا أن نستخلصه من خلال النصوص التطبيقية للفن من نحو: نصوص القرآن الكريم، ونهج البلاغة، والأدعية، والأحاديث الواردة عن أهل البيتعليهمالسلام ، كما أشرنا سابقاً.
الفنّ وعناصره:
العنصر التخيُّلي
قلنا: إنّ ( الفن ) يتميّز عن التعبير العلمي أو العادي بكونه يعتمد - في نقله أو كشفه للحقائق - عنصراً خارجياً، يمتزج مع الواقع وفق نمط خاص هو إحداث علاقة جديدة بين الأشياء، كالعلاقة التي لاحظناها بين ( الإنفاق ) و( الحبّة التي أنبتت سبع سنابل ).
إنّ إحداث مثل العلاقة يتضمّن مجموعة من العناصر، التي تشكل بمجموعها سمة ( الفن )، وهي عناصر قد يستقلّ بعضها عن الآخر حيناً، وقد تتداخل فيما بينها حيناً آخر. والمهم هو أن نقف عند هذه العناصر، ونبدأ ذلك بالحديث عن عنصر ( التخيّل ).
( العنصر التخيّلي ) - كما أشرنا - يُعدّ من أهم عناصر الفن، إن لم يكن العصب الرئيسي فيها، ويُقصد به - كما هو واضح -: ما يقابل عنصر ( الواقع ) بالنحو الذي تقدّم تفصيل الكلام فيه في الحقل الأول، إلاّ أنّنا هنا نستهدف عرض هذا العنصر من خلال خصائصه التي ينبغي أن يستخدمها الكاتب وفق المبادئ الإسلامية لها.
إنّ تصوّرات الأرضيين - أي الكُتّاب المنعزلين عن السماء - لعنصر ( التخيّل )، لا تُحدَّد في معايير خاصة بقدر ما تتجه إلى إحداث علاقة جديدة من الأشياء تُحقّق ( الإثارة ) للمتلقّي، بغضّ النظر عن كون هذه ( العلاقة ) خاضعة للإمكان أو الإحالة، للواقع أو الوهم، للصدق أو الكذب، بيمنا يختلف الأمر في التصوّر الإسلامي لهذا الجانب.
ويمكننا ملاحظة المعايير التي ينبغي أن يستند عنصر ( التخيّل ) لها، من خلال الركون إلى ( الفن التشريعي )، أي أنّ الفنان الإسلامي بمقدوره أن يستند إلى نصوص القرآن الكريم وأحاديث أهل البيتعليهمالسلام في استخلاص المعايير، أو المبادئ إلى تحكم عنصر ( التخيّل ).
إنّ أول هذه المعايير هو:ارتكان عنصر ( التخيّل ) إلى ( الواقع ) ، سواء أكان هذا الواقع ( حسّياً )، أم ( نفسياً )، أم ( غيبياً )...
( فالواقع ) - وهذا ما يمكن رصده من جوهر معرفتنا بمبادئ الإسلام - إمّا أن يكون ( حسّياً ) يعتمد الحواس المعروفة من بصر وسمع ونحوهما، وإمّا أن يكون ( نفسياً ) يعتمد طبيعة الاستجابات التي نصدر عنها حيال حقيقة من الحقائق، بحيث تنعكس في واقع ( نفسي ) لا حقيقة له في الخارج ،
وإمّا أن يكون ( غيبياً ) لا يخضع لحواسّنا بقدر ما يخضع لتصوّراتنا الذهنية عنه، وهذا من نحو عوالم الغيب التي تُحدّثنا النصوص الإسلامية عنه. ولعلّ الاستشهاد بنماذج ( تشريعية )، ومقابلتها بالنماذج ( الأرضية )، يُلقي مزيداً من الإنارة على هذا الجانب من حيث افتراق كلّ من التصوّرين:الإسلامي والأرضي ، في هذا الصدد.
لقد شبّه أحد الشعراء الموروثين أحدهم بأنّه قد أخافَ أهل الشرك ببطولته، حتى إنّ النُطف التي لم تُخلق بعد قد طبعها (الخوف ) من ( الشخص ) المذكور.
إنّ عنصر ( التخيّل ) في الصورة الشعرية المذكورة، يقوم أساساً على عنصر ( وهمي ) كاذب، لا حقيقة له في كل من الواقع الحسّي، والنفسي، والغيبي...
أمّا( حسّياً ) ، فلا وجود للنُطف التي لم تُخلق بعد.
وأمّا( نفسياً ) ، فلا وجود لعالَم النفس عند النطفة حتى يمكن للنطفة أن تستجيب نفسياً. فنحن لو أحدثنا علاقة نفسية بين رجل ينفعل بالفرح الشديد مثلاً، وبين تجاوب الشجر والشمس والحيطان مع الرجل المذكور، لكانت هذه العلاقة (مقبولة) دون أدنى شك ؛ نظراً لوجود واقع نفسي هو: أنّ الرجل الذي يغمره فرح كبير يتحسّس فعلاً بأنّ الشجر والشمس والحيطان تشاركه الفرح.
صحيح أنّ هذه الظواهر لا حقيقة لفرحها في الواقع الطبيعي، إلاّ أنّ لها واقعاً في نفسية الرجل المذكور ؛ نظراً لكونه قد خلعَ أحاسيسه عليها، وهو أمر نحياه جميعاً في تجاربنا اليومية. وهذا بعكس النطفة التي لا وجود لها، فضلاً عن كونها ذات ( نفس ) تخلع أحاسيسها على الأشياء.
من هنا يُعدّ مثل هذا ( التخيّل ) فاسداً من وجهة النظر الإسلامية ؛ نظراً لكونه يعتمد ( الوهم ) و( الكذب )، وهما من الظواهر المنهيّ عنها إسلامياً ؛ بصفة أنّ الإسلام يطالبنا بأن نتعامل في سلوكنا مع الواقع وليس مع الوهم.
هنا قد يثار سؤال عن بعض الصور القرآنية، أو الصور التشريعية الأخرى التي تبدو وكأنّها لا تخضع بدورها إلى طابع حسّي أو نفسي، مثل: صورة ( الحجارة ) التي شبّه القرآن الكريم قلب الشخصية اليهودية بها في قوله تعالى:( فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ) ، بصفة أنّ الحجارة لا تملك قلباً حتى توسم بالقساوة أو الليونة.
والحقّ أنّ الحجارة - وفقاً للمفهوم الإسلامي - تملك قدرات واعية، مثل التسبيح والخوف من الله، وهو أمر أوضحته النصوص القرآنية ذاتها عندما عقّبت على الصورة المذكورة بأنّ من الحجارة ما تتأثّر من خشية الله، وأنّ الوجود بأكمله - ومنه الحجارة طبعاً - يمارس عملية التسبيح:( وَإِن مِن شَيْءٍ إلاّ يُسَبّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِن لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ... ) ، وهذا يعني أنّ الصورة ارتكنت إلى ( الواقع ) وليس إلى ( وهم )، كما هو شأن الصورة الشعرية المشار إليها.
مضافاً إلى أنّنا لو نظرنا إلى الحجارة منعزلة عن الوعي المذكور، فإنّ تشبيه قساوة القلب بها يَحمل ( واقعاً نفسياً )، هو: إحساس الشخص بأنّ انعدام الشَفَقة عند الشخصية اليهودية يتماثل مع الحجارة في فقدانها لمسة الشفقة، أي أنّنا - بصفتنا أشخاصاً واعين -
نتحسّس نفسياً وجود صلة بين قساوة اليهودي والحجارة، بينا لا وجود للنطفة حتى تتحسّس بوجود مثل هذه الصلة.
إذاً في الحالتين: ( حالة وجود الوعي عند الحجارة، وحالة فقدانه )، هناك ( واقع نفسي ) عند المتلقّي، هو: تحسّسه بوجود التماثل بين طرَفي الصورة: ( اليهودي، والحجارة ).
والأمر نفسه يمكننا أن ننقله إلى النمط الثالث من ( الواقع الإسلامي )، ونعني به ( واقع الغيب ). فالصور القرآنية التي ترتكن إلى الواقع الغيبي، تبدو - في بعض مظاهرها - وكأنّها لا ترتكن إلى ما هو ( حسّي ) أو ( نفسي )، مثل: التشبيه الوارد عن شجرة الجحيم، وكون طلعها( كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ) ، فبالرغم من أنّ ( الشياطين ) ذات كيان ( واقعي )، إلاّ أنّ الكيان المذكور لم يشاهَد ( حسياً )، لكنّه ( نفسياً ) يخضع إلى ( الواقع ) الذهني، بصفة أنّ المتلقّي يملك تصوراً ذهنياً عن الشياطين، في صورة ( الأشباح ) التي نسجها في ذهنه، وهو نسيج له ( واقع غيبي ) ما دامت الشخصية الإسلامية مؤمنة بالواقع المذكور، لا أنّه واقع وهمي لا وجود له ألبتة.
إذاً - وللمرة الأخيرة - ثَمَّة فارق كبير بين عناصر ( التخيّل ) من النصوص الإسلامية وبين النصوص الأرضية، من حيث ركون الأُولى إلى واقع ( حسّي ) أو ( نفسي ) أو ( غيبي )، وركون الأخيرة إلى واقع ( وهمي ) لا أساس له في عالَم الحقائق المشار إليها، وهو أمر يقتادنا إلى أن نكرّر - من جديد - ضرورة إفادة الفنان الإسلامي من هذا الجانب في استخدامه لعنصر (التخيّل )، لا لكونه يُجسّد حقيقة فنية فحسب، بل لكونه ينعكس أساساً على سلوك الشخصية الإسلامية أيضاً.، فالشخصية - التي تتغذّى على التعامل مع ( الوهم ) - سوف ينعكس غذاؤها ( الوهمي ) المذكور على البناء النفسي العام لها، وهو ما يتنافى مع مبادئ الإسلام التي نحرص على تحقيق أفضل صيَغها وفقاً للوظيفة العبادية التي خُلقنا من أجلها أساساً.، ويمكن - كما أشرنا - للكاتب الإسلامي أن يقوم بعملية استقراء لجميع عناصر ( التخيّل ) في نصوص التشريع ؛ حتى يستخلص منها قاعدة فنية تميّزها عن قواعد الفن الأرضي، حتى يتفرّد للإسلام اتجاهه الفنّي الخاصّ به في هذا الميدان.
التخيّلُ والصورة
إنّ عنصر ( التخيّل ) يأخذ شكلاً معيّناً من العبارة وتركيبها، بمعنى أنّنا عندما نُحدِث ( علاقة ) بين شيئين، إنّما ننشئ في الواقع مرأى، أو مشهد، أو صورة خارجية أو ذهنية، تتكوّن من طرفين: طرف أول يتضمّن الشيء الذي نخلع عليه (العلاقة الجديدة ) مثل: ( القلب ) الذي نعتزم خلع صفة خاصة عليه، ثمّ طرف آخر مثل: ( الحجر ) المتضمّن صفة (القساوة ) التي أردنا خلعها على القلب. فهناك إذاً في كل عنصر تخيّلي طرفان يمتزج بعضهما بالآخر، لينبثق منهما شيء ثالث جديد لا يحمل خصّيصة أحدهما، بل يحمل خصّيصة متميزة لها استقلالها، تماماً مثل التركيب الكيميائي لمادّتين حيث تنبثق من التركيب مادة ثالثة جديدة.
إنّ عملية التركيب التخيّلي المذكور يُطلق عليه ( في اللغة الفنية الحديثة ) مصطلح( الصورة ) ، ولعلّ المصطلح البلاغي الموروث الذي يُطلق عليه اسم ( البيان ) مقابل ( المعاني ) و( البديع ) يجسّد مفهوم ( الصورة ) التي أشرنا إليها، حيث إنّ كلاً من: ( التشبيه ) و( الاستعارة ) و( الكناية ) وغيرها، تجسّد مفهوم ( الصورة ) بمعناها التركيبي المذكور.
والحقّ : أنّ كلاً من ( المعاني والبيان ) يتضمّن الكثير من أقسامهما عنصر ( الصورة ) أيضاً، إلاّ أنّ ( البيان ) يستقلّ في ذلك.
من هنا نجد أنّ مصطلح ( الصورة ) يظل عنصراً يختزل تلكُم التفصيلات التي تتضمّنها البلاغة القديمة، ففضلاً عن أنّ البلاغة القديمة تمثل مناخاً خاصاً لا يأتلف مع حياتنا المعاصرة ( وهو أمر نعالجه في مكان آخر من هذه الدراسة )، فإنّ تفصيلاتها المرهقة للأعصاب من الممكن الاستغناء عنها واستبدالها بلغة جديدة تنسجم ( ليس مع عصر الاقتصاد اللغوي فحسب )، بل مع واقع التصور الإسلامي لمفهوم ( البلاغة )، التي وصفها الإمام الصادقعليهالسلام بأنّها تعبير عن دلالة عميقة بلغة مقتصدة.
المهم : أنّ مصطلح ( الصورة ) يظل هو المجسّد - كما قلنا - لعملية التركيب التخيّلي. ونظراً لأهمية هذا العنصر - وكونه ( السمة ) المميّزة للغة ( الفن )، وافتراقها عن لغة ( العلم ) أو التعبير العادي، ينبغي أن نُفرد له حقلاً مستقلاً نتحدّث من خلاله عن عناصر ( الصورة )، والمعايير التي ينبغي أن تحكمها لتكتسب صفة النجاح الفني، من خلال ركوننا إلى جوهر المبادئ
الإسلامية في تصورنا لعمليات الإدراك الذهني، ومن خلال ركوننا - كما كرّرنا - إلى النصوص الفنية التي نجدها في نصوص القرآن والحديث.
إنّ أول ما ينبغي التأكيد عليه هو : أنّ اللجوء لعنصر ( الصورة ) يظلّ مجرّد ( وسيلة ) لتعميق الدلالة ؛ لذلك لا نجد أنفسنا ملزَمين بالانسياق حتى مع المفهومات الحديثة للصورة ( فضلاً عن المفهومات البلاغية لها )، بل ننطلق من الإدراك الإسلامي للظواهر، حيث ( يوظّف ) كلّ شيء من أجل ( الهدف ) ؛ لذلك ليس ثَمّة معيار خاص لنجاح الصورة إلاّ بقدر ما تحقّق عنصر ( الإثارة الفنية )، أو ما أسميناه بتعميق الدلالة.
إنّ النقد الأدبي المعاصر يمتلك تصورات خاصة عن ( الصورة )، مثل كونها: تعتمد ( البُعد النفسي ) بدلاً من البُعد المادي مثلاً. ( التشبيه ) الذي يتضمّن طرفاه بُعداً ( حسّياً ) يُعدّ - في التصور النقدي الحديث - ظاهرة بدائية ؛ نظراً لأنّ البدائيين تبهرهم المظاهر الحسّية ويفتقرون إلى إدراك الدلالات المعنوية للشيء.
من هنا، فإنّ أحد طرَفي الصورة أو كليهما، إذا بُدّل بما هو ( نفسي )، يجعلها أشدّ قرباً من النجاح. كما أنّ ( الاستعارة ) تُعدّ أشدّ نجاحاً من ( التشبيه ) ؛ لأنّها تَحذف ( أداة التشبيه ) البدائية. و( الكناية ) تُعدّ أشدّ منهما نجاحاً ؛ لأنّها تحذف ( ليس أداة التشبيه ) فحسب، بل حتى طرَفي الصورة، وتتحوّل إلى ( رمز ) للشيء بدلاً من إدراك طرفين محدّدَين له. من هنا أيضاً يُعد ( الرمز ) أشدّ أشكال الصورة نجاحاً في العمل الفني في تصور النقد الأدبي الحديث.
أمّا إسلامياً، فلا نجد أنفسنا ملزَمين بهذا التصوّر بقدر ما ينبغي أن نعتمد التصوّر الإسلامي للفن، من خلال الوقوف على لغة القرآن والحديث من جانب، والإفادة من المعرفة النفسية الحديثة من جانب آخر، حيث إنّ المعرفة الأخيرة تحدّد لنا بوضوح: أنّ المهم هو تحقيق عنصر ( الإثارة ) بغضّ النظر عن بدائية الأداة الفنية أو حداثتها، إذ مَ الفائدة من استخدام (الرموز ) فحسب إذا كان استخدامها لا يحقق العنصر الإثاري، كما أنّه مَ الفائدة من استخدام ( البلاغة الموروثة ) إذا كان استخدامها قاصراً عن تحقيق عنصر ( الإثارة ) الفنية ؟!
الفائدة تتمثَّل في الركون إلى استخدام أيّة ( أداة ) فنية لتعميق الدلالة، وهو ما نلحظه بوضوح في لغة القرآن الكريم بخاصة، حيث نظفر بحصيلة ضخمة من النماذج التي تعتمد اللغة البلاغية حيناً، وتعتمد اللغة ( الرمزية ) حيناً آخر، حسب ما يستدعيه السياق، وهذا هو المعيار الإسلامي للفن فضلاً عن كونه يتّسق مع الإدراك العقلي السليم للظواهر.
وتأسيساً على ما تقدّم، نحاول الآن الوقوف على الأشكال المختلفة لعنصر ( الصورة )، من خلال الوقوف على النص القرآني الكريم بُغية استخلاص المبادئ الفنية لها، والإفادة منها في العمل الفني الإسلامي.
إنّ ( الصورة ) قد تكون ( مفردة ) تتألّف من ظاهرتين يُجمع بينهما لإحداث ظاهرة ثالثة، مثل صورة ( الكفّار ) وتشبيههم ب-( الأنعام )( إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ ) . وقد تكون ( متعددة ) تتألّف من مجموعة ( صور )، مثل:( مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ ) ... إلخ، فهنا مجموعة من الصور ( المفردة ): (النور والمشكاة )، ( المصباح والزجاجة )، ( الزجاجة والكوكب الدرّي )... إلخ، إلاّ أنّ مجموع الصور يؤلِّف صورة واحدة.
والمهم : أنّ السياق هو الذي يحدّد نمط الصورة وكونها مفردة أو متعددة، كمثال الكفّار وتشبيههم بالأنعام، حيث إنّ الهدف هو إبراز التماثل بين الطرفين من خلال فقدان التميّز بينهما، وحينئذٍ يكفي اقتناص بُعد واحد يشتركان فيه. والأمر كذلك بالنسبة لتشبيه الحور - مثلاً - باللؤلؤ أو الياقوت ونحوهما ؛ حيث إنّ الهدف هو إبراز البُعد الجمالي للحور.
أمّا حين يستدعي الموقف تفصيلاً للشيء، فحينئذٍ يجيء المسوّغ الفني لتعدّد الصور، مثل الصورة المتعدّدة للنور ؛ حيث إنّ إبراز المعطيات المتنوّعة للنور وتعدّد أبعاده يفرض صوراً متعدّدة. والأمر كذلك بالنسبة لنماذج أخرى تتعدّد صورها، مثل: قضية ( الإنفاق )، حيث يُشبّه النص الإنفاق بالحبّة، الحبّة تنبت سبع سنابل، السنبلة تحمل مئة حبّة، ومثل: تشبيه قساوة اليهودي بالحجر، وأنّه أشدّ قسوة، وأنّ الحجر تتفجّر منه الأنهار... إلخ، فالإنفاق بصفته يستتبع تعويضاً دنيوياً وأخروياً من حيث مضاعفة ذلك ؛ فإنّ المضاعفة حينئذٍ تستدعي صوراً متعدّدة تتناسب مع عملية المضاعفة.
إذاً السياق أو الموقف هو الذي يحدّد نمط الصورة، سواء أكانت مفردة أم متعددة، وسواء أكانت متداخلة أو متتابعة، أو غير ذلك من أشكال التركيب الصوري الذي فصّلنا الحديث عن مستوياته في الحقل الأخير من هذه الدراسة، ونعني به الحقل المتصل بالفن التشريعي، حيث يحسن بالفنان الإسلامي الوقوف على المستويات المذكورة ؛ للإفادة منها في كتابة الفنّ الإسلامي الملتزم، وجعلها مبادئ ومعايير عامة لعنصر الصورة وطرائف صياغتها.
* * *
إنّ عنصر ( الصورة ) - بنحوها المتقدّم - يُستخدم عادة في العمل الشعري أو الخاطرة ونحوهما، وتضْؤُل نسبته أو تنعدم في الأعمال القصصية والمسرحية، حيث يُعوّض عنها بعنصر مباشر هو ما يمكن تسميته باللَقطة، أو المرأى، أو المشهد،...
والفارق بينالصورة غير المباشرة وبين الصورة المباشرة هي : أنّ الأُولى تعتمد عنصر الإحداث لعلاقة جديدة بين الأشياء مثل: ( العلاقة بين الحور واللؤلؤ ). أمّا الصورة المباشرة، فهي تتحدّث عن الواقع مباشرة، دون إحداث علاقة بين أطرافه، فعندما يتحدّث النص القرآني عن أقوام نوحعليهالسلام ، وإلى أنّهم يضعون أصابعهم في آذانهم، ويضعون ثيابهم على وجوههم عندما يواجهون نوحاً... هذه الصورة ( وضع الثياب على الوجه، والأصابع في الأذان )، لا تقوم بإحداث أيّة علاقة جديدة بين مفردات الواقع، بل تنقل مفرداته بصورتها الواقعية...
والمهم: أنّ نمط الشكل الفني من جانب ( القصيدة، القصة... إلخ )، ونمط الموقف، يفرض نمط صياغة الصورة وكونها ( رمزاً ) للواقع أو تعبيراً مباشراً عنه. ففي وصف جنّة السابقين في سورة ( الواقعة ) مثلاً، نجد أنّ الصورة - بنمطيها المباشر وغير المباشر - تأخذ صياغتها وفقاً لمتطلّبات الموقف، حيث يجيء وصف السُرر وكونها مَوْضُونة، والشرب من خلال الأباريق والكؤوس والأكواب وغير ذلك، ويجيء وصفه مباشراً ؛ نظراً لكون ( الواقع ) كذلك.
إلاّ أنّ النص ما أن يصل إلى ( الحور ) حتى يتجه إلى عنصر ( الصور ة غير المباشرة )، فيصوغ ( تشبيهاً ) بينها وبين اللؤلؤ المكنون ؛ نظراً لِما يتطلّبه الموقف من صياغة ( رمز )، لا ( واقع حسّي ) للحور، فثمّة قيمة أخلاقية لا تسمح للمتلقّي بأن يتعامل مع عنصر ( الجنس ) بنفس التعامل مع عنصر ( الطبيعة ) ؛ لأنّ الأخير موضع تعامل الجميع، بينا الأول موضع تعامل خاص ينحصر في الحياة الزوجية الخاصة، حيث يتطلَّب الموقف عدم الوصف المباشر من جانب ( وهو المسوّغ الفني للرمز )، وعدم تفصيلات ذلك من جانب آخر ( وهو المسوّغ الفني لكون الرمز يأخذ شكل الصورة المفردة وليس الصورة المتعدّدة ).
وأيَّاً كان، فإنّ ( الصورة ) بعامة تظلّ أداة من أدوات ( الفن ) المرتبطة بعنصر ( التخيّل )، ألا وهي: إحداث علاقة جديدة بين مفردات الواقع. وبالرغم من أنّ هناك أشكالاً، أو أدوات أخرى، ترتبط بعنصر ( التخيّل )، فيما نتحدّث عنها عند معالجتنا لأشكال الفن: ( مسرحية، قصة، خطبة، خاطرة... إلخ )، إلاّ أنّ هدفنا هنا هو: تبيين ( عناصر ) الفن العامة، حيث يجيء ( التخيّل ) في مقدّمتها، وحيث تجيء العناصر الأخرى متمّمة لماهية ( الفن ) من حيث عناصره، ومنه عنصر:
العنصرُ العاطفي
يُقصد ب-( العاطفة ) ما يقابِل( الفكر ) ، فالإدراك البشري يقوم على العنصرين المذكورَين أساساً، كلّ ما في الأمر أنّ النسبة العاطفية ينبغي أن تأخذ حجماً صغيراً من مساحة الاستجابة البشرية للأشياء. فإذا تلقّينا نبأً سعيداً أو مؤلماً مثلاً، ينبغي ألاّ نسمح للبُعد العاطفي أن يسيطر على استجابتنا، وفقاً للآية الكريمة التي تطالب بألاّ نأسى على ما فاتنا ولا نفرح بما أتانا...
طبيعياً أنّ العنصر ( العاطفي ) يفرض ضرورته في موقف مثل: عاطفة الأُبوّة والأمومة والبنوّة ونحوها، حتى إنّ الأُم - على سبيل المثال - لو لم تتضخّم عاطفتها حيال طفلها لمَا أمكنَ أن تتحمّل متاعبه... بَيْدَ أنّ ذلك كلّه - وفقاً للتصور الإسلامي - ينبغي ألاّ يتجاوز المنحني المتوسط للتعامل، فالمشرِّع الإسلامي يطالب الأبوين - مثلاً - ألاّ يُضخِّموا عواطفهم حيال الأولاد إذا لم يفلحوا في تعديل سلوكهم، مطالِباً إياهم أن يَكِلُوا أمرهم إلى الواقع.
إنّ مثل هذه المطالبة بتوكيل أمر الأولاد إلى الله، ولفت نظر الأبوين إلى أنّ سلوك أولادهم لو لم يكن مرضيّاً عند الله فلا حاجة إلى القلق حيالهم، وإذا كانوا مرشّحين إلى أن يصبحوا أسوياء ذات يوم، فإنّ أمرهم موكول إلى الله... ففي الحالتين يطالب الشرع الإسلامي الأبوين بعدم تصعيد عاطفتهما حيال الأولاد، مع أنّهم أشدّ المنبّهات إثارة لديهم...
لقد طالبَ الله إبراهيم بأن يتخلّى عن أبيه، وطالبَ نوحاً بأن يتخلّى عن ابنه، وأن يتّجها بمحبّتهما إلى الله بدلاً من الابن والأب، وهذا يعني أنّ التصعيد العاطفي بنَمطيه - المشروع وغير المشروع - محظور في التصوّر الإسلامي لعنصر ( العاطفة )، بل أشدّ المواقف إثارة، وهو فقدان القريب أباً أم ابناً مثلاً، يطالب المشرّع الإسلامي بعدم شقّ الجيب وخمش الوجه، وحتى بعدم مجرّد ضرب اليد على الجسم مثلاً عند المصيبة، وهو أمر يكشف بوضوح أنّ المبالغة العاطفية أمرٌ - كما أشرنا - محظور عند المشرّع الإسلامي...
إذا أدركنا هذه الحقيقة، عندئذٍ يمكننا أن نتعرّف حقيقة الاستجابة العاطفية حيال أشدّ المواقف إثارة... أمّا لو نقلنا الحقيقة إلى الاستجابات العادية للأشياء، لأمكننا ملاحظة أنّ الحظر العاطفي يأخذ شكلاً حادّاً عند المشرّع الإسلامي، فهو يمنع الغضب والغيبة والعدوان عموماً بصفتها تعبيرات عاطفية... كما يطالب بالعفو، والإحسان، والإنفاق ونحوها من الاستجابات التي
تكظم الانفعال...
كل أولئك يكشف لنا أنّ ( التعبير العاطفي ) إذا اكتسبَ سمة المبالغة يظلّ مطبوعاً بالحظر، ومن ثمّ يظلّ مطبوعاً - في اللغة النفسية - بِسمِة المرض أو الشذوذ... وإذا كان الأمر كذلك، حينئذٍ فإنّ نقل هذه الحقيقة إلى ( العمل الفني ) لابدّ أن تأخذ نفس السمة المحظورة، بصفة أنّ الفن أحد أشكال الاستجابة البشرية حيال الأشياء.
بَيْدَ أنّ ثمّة فرقاً بين مطلق التعبير العاطفي - كما قلنا - وبين المبالغة فيه، فالعاطفة ما دامت تُشكّل أحد وجْهَي الاستجابة ( الفكر والعاطفة ) حينئذٍ لابدّ أن تأخذ نصيبها من العمل الفني أيضاً، مع ملاحظة أنّ أدواته من ( تخيّل ) و( إيقاع ) ونحوهما تساهم في التصعيد العاطفي، إلاّ أنّه في نطاق محدّد.
وبكلمة جديدة : إذا كان المشرّع الإسلامي يسمح - على سبيل المثال - بالتصعيد العاطفي في مواقف خاصة، مثل: عاطفة الأُم حيال طفلها الصغير، أو عاطفة الجندي في ساحة المعركة، أو عاطفة الشخص حيال قريبه، فإنّ ( العمل الفني ) يُعدّ واحداً من هذه المواقف التي يتصاعد من خلاله العنصر العاطفي لإحداثه إثارة خاصة عند المتلقّي.
فنقلُ الفنان لأحد مشاهد الطبيعة الجميلة، أو لأحدى المعارك العسكرية، أو التثمين لإحدى شخصيات المعصومينعليهمالسلام مثلاً، عندما يقترن بالتصعيد العاطفي لها، حينئذٍ يكتسب صفة المشروعية دون أدنى شك ؛ لأنّ التصعيد المذكور يجعل التواصل مع الله تعالى من خلال مشاهد الطبيعة، أو المعارك الإسلامية، أو شخصيات المعصومينعليهمالسلام ، أشدّ حجماً من الاستجابة العادية.
وثمّة فرق بين التصعيد العاطفي وبين المبالغة أو التورّم: فالأول تفرضه حقائق الواقع، والآخر يتسبّب عن شذوذ أو مرض، كما قلنا. في ضوء ما تقدّم يمكن القول: بأنّ ما يميّز العمل الفني عن غيره، هو تصعيد ( العنصر العاطفي ) فيه، دون الوقوع في المبالغة، إلاّ أنّ هذا التصعيد لا يطبع كلّ الأشكال الفنية، بل بعضها، بخاصة: (القصيدة)، بل أحد أشكالها فحسب، وهو ما يطلق عليه اسم( القصيدة الغنائية ) . ومثلها( الخطبة ) ، حيث يتطلب الموقف تحريك الجمهور واستثارة عواطفه.
كما أنّ القصيدة الغنائية - بصفتها تعبيراً عن حالة انفعالية لكاتبها - لابدّ أن تُطبع بالسمة العاطفية... وأمّا الأشكال التعبيرية الأخرى، من قصة ومسرحية ونحوهما، فإنّ العنصر العاطفي يضمر فيها وقد ينعدم أحياناً. ولكن من الممكن أن يتصاعد فيها العنصر العاطفي أيضاً تبعاً لمتطلّبات الموقف.
بعامة أنّ العنصر العاطفي يُشكل واحداً من شطرَي العملية الفنية: ( التخيّل، العاطفة )، حتى إنّه لا يكاد ينفصم أحدهما عن الآخر، فنحن عندما نصف بطلاً عسكرياً مثلاً بأنّه يهدر كالعاصفة في ساحة المعركة، إنّما نصدر عن عنصرَي: ( التخيّل والعاطفة ). أمّا عنصر التخيّل، فيتمثّل في إحداث علاقة بين البطل والعاصفة من خلال أداة التشبيه.
وأمّا عنصر العاطفة، فيتمثّل في كوننا قد انفعلنا حيال البطل حتى تصاعدَ انفعالنا إلى درجة التداعي إلى العاصفة، واستحضارها في الواقع النفسي لها، بل يمكن القول: بأنّ ( التخيّل ) هو الشكل الخارجي للفن، وأنّ ( العاطفة ) هي الشكل الداخلي له.
وبكلمة جديدة : يمكن أن نستعير لغة خاصة فنقول: إنّ ( الفن ) يقوم على ( التخيّل العاطفي ) للأشياء، كلّ ما في الأمر أنّ ( التخيّل ) ينبغي أن يتسم بصفة الواقع النفسي أو الحسّي أو الغيبي كما تقدّمت الإشارة في حقل سابق. وإلى أنّ ( العاطفة ) ينبغي أن تضبطها سمة ( العقل )، بمعنى أنّه ينبغي ألاّ تطبعها سمة ( المبالغة ) كما قلنا ؛ انطلاقاً من التصوّر الإسلامي لعنصر ( العاطفة )، حيث تحدّثنا - قبل صفحات - عن مستوياته التي ينبغي أن يصدر الكاتب الإسلامي عنها.
وفي تصورنا أنّ مستوى التعبير العاطفي ونسبة استخدامه، يمكن أن نستخلصهما من التوصيات والنصوص الفنية: ( القرآن الكريم، النهج... إلخ ). أمّا التوصيات، فتحدّد لنا ( مستوى ) العاطفة. وأمّا النصوص الفنية، فتُحدّد الدرجة أو النسبة العاطفية. فلو قُدّر لنا أن نتأمّل أيّة سورة قرآنية كريمة ( عدا البعض الذي تتضخم أو تضمر فيه النسبة )، لأمكننا القول: بأنّ النسبة تأخذ حجماً صغيراً من مساحة السورة، بحيث لا تصل - في حالة تصاعدها - إلى درجة التكافؤ بينها وبين العنصر المباشر أو الفكر.
وهنا ينبغي لفت النظر إلى الفارقية بين النص القرآني الكريم وبين مطلق التعبير الفني البشري، فالنّص القرآني - بصفته كلام الله تعالى، وإلى أنّه تعالى ( منزّه ) عن التجسيم، حينئذٍ لا يمكن أن نتحدّث عنه من خلال المعايير البشرية، بل نستهدف الذهاب إلى أنّ الله تعالى ( يراعي ) الاستجابة البشرية، فيصاغ النص وفقاً لنسبة معيّنة من العنصر العاطفي الذي يستجيب القارئ حياله. ولذلك عندما نقول: إنّ ( العنصر العاطفي ) في النص القرآني يحتل نسبة صغيرة من مساحة النص، إنّما يُقصد بذلك: العنصر المتصل بانفعال الأشخاص حيال أحد المنبّهات التي يعرضها النص.
وبكلمة أخرى: ينبغي أن نضع فارقاً بين النص الفني الذي يأخذ استجابة الجمهور في الاعتبار، فيخاطبهم بقدر عقولهم ( فكراً وعاطفة )، وبين النص الفني الذي يصدر عن كاتبه، وذلك مثل القصيدة الغنائية، فهذه القصيدة ( تعبير عاطفي ) عن صاحبها، أي أنّ صاحبها ينفعل بأحد المواقف فيترجم انفعاله إلى قصيدة.
وأمّا القصيدة ( الموضوعية )، فلا تعبّر عن ( انفعال ) صاحبها، بل إنّ صاحبها يحاول أو يصوغ قصيدته وفقاً لانفعالات ( الآخرين )، أي أنّه يصوغها وفقاً لمعرفته بقوانين أو مبادئ الاستجابة البشرية للأشياء، وهذا ما يطبع النص القرآني الكريم الذي يخاطب المتلقّي وفق نسبة صغيرة من العواطف التي يصدر البشر عنها، بحيث يمكن القول في نهاية المطاف: إنّ العنصر العاطفي يظل - في المنحني المتوسط - بمثابة الملح للطعام أو الماء للنبت، مع مراعاة المواقف المختلفة التي تتصاعد أو تتضاءل النسب العاطفية فيها، تَبعاً للمتطلبات التي تُحدّد ذلك، بالنحو الذي تقدّم الحديث عنه.
* * *
إنّ كلاً من عنصرَي: ( العاطفة ) و( التخيّل )، إذا كانا يجسّدان وجْهَي عملية ( الفن ) ؛ فلأنّهما - من جانب - يمكن أن يتّحدا في عملية واحدة، حيث قلنا بأنّ العاطفة هي البطانة الداخلية
للعمل الفني، وأنّ التخيّل هو مظهره الخارجي المتمثّل في عنصر ( الصورة ). كما أنّهما - من جانب آخر - يمكن أن ينفصلا، كما لو عبّرنا انفعالياً عن أحد المواقف دون أن نرتكن إلى عنصر ( الصورة ) مثلاً، حيث يظل الانفعال أو العاطفة هو البطانة العامّة للعمل الفنّي.
والحقّ أنّ ( العاطفة ) من النادر أن تستقلّ في عمل فني بقدر ما تتوسل بأدوات أخرى مثل ( التخيّل )، الذي أوضحنا صلته بالعنصر العاطفي، ومثله أدوات أخرى يجيء في مقدّمتها عنصر:
العنصرُ الإيقاعي
يُقصد ب-( الإيقاع ) : الأصوات التي تنتظم في شكل خاصّ من التعبير، بحيث يبتعث الإثارة والإمتاع والإحساس بالجمال عند المستمع. وبكلمة مبتذلة: يُقصد به ما يطلق عليه اسم ( الموسيقى ) في اللغة المألوفة.
إنّ الإيقاع يعدّ من أهم السمات التي تميّز ( الفن ) عن سواه، من حيث الشكل الخارجي له ؛ ولعلّ سرّ ذلك مرتبط بطبيعة التركيبية البشرية التي تقوم حركاتها وتعبيراتها على أساس من الانتظام في الحركة الجسمية، وفق العبارة المنطوقة.
وإذا كان ( الفن ) قائماً على أساس انفعالي أو عاطفي، فإنّ الإيقاع يظلّ واحداً من أشدّ الأشكال تعبيراً عنه، بصفة أنّ العاطفة تُستثار حينما تواجه ( منبّهاً ) يلّح على وجدان الشخص أو تركيبته النفسية، وهي تركيبة قائمة على أساس ( منتظم ) في الحركة والنطق كما أشرنا. ولعلّ الإثارة التي تبتعثها أناشيد الحماسة مثلاً، أو الخطب الخاصّة، أو القراءة المنغّمة والمرتّلة، تفسّر لنا صلة ذلك بالتركيبة البشرية المشار إليها.
من هنا، فإنّ النص القرآني الكريم أخذَ هذا الجانب الإرثي من الشخصية بنظر الاعتبار، حيث تحتشد عباراته بصنوف مختلفة من الإيقاع المدهش، كما تحتفظ بنسبة ضخمة جداً من العنصر المذكور إلى الدرجة التي تلفت الانتباه، حتى إنّنا لا نكاد نمرّ بسورة، أو مقطع، أو حتى الآية المفردة، إلاّ ونجدها ذات طابع إيقاعي خاصّ، وهو أمر يفسّر لنا أهمية هذا العنصر وضرورته التي لا مناص منها في العمل الفنّي.
طبيعياً ثمّة فوارق بين نمَطين من الإيقاع: أحدهما يتسم بالضرورة الفنية التي أشرنا إليها، بينا يتّسم النمط الآخر من الإيقاع بسمة معكوسة تماماً، أي الحظر التشريعي له، حتى ليصل ذلك إلى درجة الحرمة وليس مجرّد الكراهة ( وهو أمر نتحدّث عنه مفصّلاً، عند معالجتنا لظاهرة الغناء التي حرّمها المشرّع الإسلامي تحريماً قاطعاً ).
المهم : أنّ النمط المتَّسم بالضرورة الفنية، يمكن - في ضوء النصوص الفنية التشريعية - استخلاص مبادئه أو أشكاله متمثِّلة في: جرس العبارة، التجانس، التوازن.
ونقصد ب- ( الجرس ): طبيعة الحروف التي تتنظم في كلمة ( بما أنّها منطوقة )، وتأخذ سياقاً خاصاً
في مجموع الكلمات.
ونقصد ب-( التجانس ) : تماثل الأصوات بين المجموع المشار إليه، أي تماثل صوت الكلمة الواحدة مع الأخرى.
وأمّا( التوازن ) : فنقصد به خضوع الأصوات لنظام صوتي متكرّر موحّد، مثل أوزان الشعر، ومثل العبارة الخاضعة لنمط موزون.
وهناك نمط رابع من ( الإيقاع ) يُطلق عليه في اللغة الفنية اسم( الإيقاع الداخلي ) ، ويُقصد به تجانس الأصوات مع دلالة العبارة.
إنّ هذه الأشكال الأربعة من ( الإيقاع ) يمكن استخلاصها بوضوح من النصّ القرآني الكريم، والنصوص الواردة عن النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم وأهل بيته (ع)، ومن ثمّ يمكن الإفادة منها في استخلاص مبادئ عامّة في التصوّر الإسلامي لظاهرة ( الإيقاع )، واستثمار ذلك في العمل الفنّي الإسلامي.
إنّ ما نستهدفه - في الحديث عن الإيقاع - هو: الإفادة من العنصر المذكور في إكساب العمل الفني بُعداً جمالياً يساهم في شدّ المتلقّي نحو هذا العمل. كلّ ما في الأمر أنّ استخدام هذا العنصر ينبغي أن يتمّ وفقاً للمزاج الذي يطبع عصر الفنان.
فالسجع - على سبيل المثال - لا يأتلف مع الحياة المعاصرة، التي هَجرت ذلك التراث المسجوع الذي أفرزته القرون الغابرة مطبوعاً بسمة التكلّف، وهي سمة فرضها انغلاق التيار الثقافي عصرئذٍ، على الضدّ من العصر الحديث الذي ألِفَ مختلف التيارات، ممّا جعلهُ يُؤثر التلقائية والسهولة والوضوح بدلاً من التكلّف والالتواء.
إنّ الكاتب الحديث قد يلجأ إلى العمارة المسجوعة، إلاّ أنّ ذلك يتم في موقع أو موقعين من مساحة النص مثلاً، مع انسيابية ملحوظة وإحكام في العبارة... هذه الانسيابية ذاتها تنسحب على الأشكال والمستويات الإيقاعية الأخرى من حيث: ( جرس ) الكلمة، و( تجانس ) الأصوات، و( توازن ) الجُمل، أو التعديلات، أو الأسطر الشعرية.
المهم أنّ مراعاة المناخ الثقافي تفرض على الفنان الإسلامي أن ينتخب من الإيقاع ما يتوافق مع المناخ المذكور، وهو أمر لعلّه يفسّر لنا سرّ التنوّع والتفاوت الملحوظَين في النصوص التشريعية - في مقدّمتها نصوص القرآن الكريم - حيث لا ينحصر عنصر الإيقاع في عبارات مسجوعة أو مرسلة، بل يراوح بينهما حيناً، ويؤثر أحدهما على الآخر حيناً آخر، حسب ما يقتضيه السياق، فضلاً عن أنّ التنوّع في ذلك يدع كلّ عصر يتجاذب فنياً مع النوع الإيقاعي الملائم له.
وإذا كان الإيقاع المتصل بما أسميناه ب- ( التوازن ) يخضع لنسبية العصر الذي ينتمي الفنان إليه، مثل انتخابه للإيقاع العمودي أو الحرّ أو النثري ( في مجال القصيدة )، ومثل: انتخابه للإرسال أو السجع، أو انتخابه للجملة المتوازنة مع أختها، أو المتحرّرة من ذلك ( في مجال النثر )، إلاّ أنّ الأشكال الإيقاعية الأخرى تظل مطلقة غير خاضعة لنسبية العصر ؛ بصفة أنّ ( جرس ) الكلمة، و( تجانس ) الأصوات، وتجاوب الدلالة الفكرية مع الإيقاع اللفظي لها ( أي الإيقاع الداخلي )، أولئك
جميعاً تظل من السمات المشتركة للفن، بحيث إنّ الانسلاخ عنها يُفقد العمل الفني جماليّته التي تميّزه عن الكلام العادي أو العلمي.
العنصرُ البنائي
إنّ كلاً من عناصر: ( التخيّل ) و( الانفعال ) و( الإيقاع )، لا يأخذ أهميته إلاّ من خلال انصبابه في هيكل موحّد، تتلاحم أجزاؤه وتتفاعل بعضاً مع الآخر، بحيث يمكن القول بأنّ: ( الموضوع ) - أو ( الأفكار ) الإسلامية المصاغة وفق عناصر التخيّل والانفعال والإيقاع - يبدأ من خط معيّن وينتهي إلى خط نهائي، تتواشج جزئياته على نحو ما نلحظه في الخطوط الهندسية التي تنتظم عمارة فخمة تبتعث الدهشة بناءً وجماليّة.
إنّ المواد الأولية للعمارة تتمثَّل في ( العناصر ) المشار إليها، مضافاً إلى عنصر ( اللغة ) التي أهملنا الحديث عنها ؛ نظراً لوضوحها في الأذهان من حيث كونها ( الأداة ) التي تتم من خلالها عملية ( البناء )، وهي أداة تعتمد الوضوح والإحكام والجمالية في صياغتها.
طبيعياً ينبغي أن نفرز بين نمطين من البناء: بناء الموضوع من حيث جزئياته ( الفكرية )، وبناء العناصر المشار إليها من حيث اندماجها وتوحّدها في الموضوع المذكور. فالموضوعات تتنامى أجزاؤها وتتلاقى بالنحو الذي تتنامى من خلاله عروق الشجر وأغصانه وأوراقه وثماره، ثمّ تتلاقى وتتجانس، وتتقابل فيما بينها عِبر عملية النمو من جانب، وحصيلته من جانب آخر.
كما أنّ عناصر: التخيّل والانفعال والإيقاع ( تندمج ) ضمن عمليّة النّمو المذكورة، لتَهبها: ( لوناً ) و( حركة ) و(رائحة) لا ينفصل أحدها عن الآخر، كما لا تنفصل جميعاً عن أصولها المذكورة.
طبيعياً أيضاً أنّ عمليات التنامي والتجانس والتقابل، قد تخضع للزمن الموضوعي ( أي التسلسل التاريخي للحَدث أو الموقف الذي يعالجه النصّ الفني )، وقد تخضع للزمن النفسي ( أي عمليات التداعي الذهني واستطراداته وتوجّهاته )، حيث يفرض الموقف نمط النمو العضوي الذي يُنتجه الفنان من حيث كونه نموّاً تاريخياً أو نفسي.
المهم أنّ مطالبة الملتزم الإسلامي بتحقيق هذه الوظيفة النمائية لعمله الفنّي، إنّما تنطلق من طبيعة النصوص الشرعية التي روعيَ فيها جانب البناء العِمَاري بنحو ملحوظ، وفي مقدّمتها نصوص القرآن الكريم. فالسِّور القرآنية جميعاً - بدءاً من أصغرها حجماً إلى أكبرها حجماً - ينتظم كلاً منها بناء خاص ( بنمطيه الزمني والنفسي )، سواء أكانت موضوعاتها ( موحّدة ) كما هو شأن غالبية السور
القصار، أو كانت ( متنوّعة ) تتضمّن عشرات الموضوعات المختلفة كما هو طابع السور الكبار، حيث يخضع الموضوع الواحد لعملية ( تنام ) لجزئياته، وحيث تخضع الموضوعات المتنوّعة لنفس ( التنامي )، بعد أن تكون هذه الموضوعات إمّا منصبّة في ( محور ) فكري واحد تحوم عليه، أو مَحاوِر متنوّعة تتلاقى عندها، أو تتقابل عندها، لتشكل في النهاية خطوطاً متوازية أو متجانسة، وبما أنّ هذه الدراسة خَصّصت الحقل الأخير منها لمعالجة النصوص الشرعية ( ومنها: الجانب العماري للسورة أو الحديث )، حينئذٍ نُحيل القارئ إلى ملاحظة الحقل المذكور.
بَيْد أنّ ما تجدر ملاحظته هنا أنّ عملية ( البناء ) الفني، فضلاً عن أنّ مسوّغاتها الشرعية هي التي تفسّر لنا السرّ الكامن وراء مطالبة الكاتب الإسلامي بالتوفّر على هذا الجانب، إلاّ أنّه - إلى جانب ذلك - يمكن التدليل فنياً على أهميته البناء ؛ من خلال إدراكنا بأنّ وظيفة العمل الفني هي إحداث الإثارة في النفوس بغية تعديل السلوك العبادي للشخصية، حينئذٍ فإنّ استخدام أشدّ الوسائل عمقاً في التأثير يظلّ هو الهدف الذي يرصده الكاتب عادة.
ومن البيّن أنّ الإدراك البشري ( وهو ما فصّلتْ الحديث عنه إحدى مدارس علم النفس الحديث - الاتجاه - الشكلي ) يستجيب فطرياً ل- ( الكل ) وليس ل- ( الجزء ) المنفصل عنه، بمعنى أنّ استجابته للكل، أو ميله إلى ( تكملة ) ذلك في حالة التفكّك أو الخلل، تظلّ أشدّ تحقيقاً لعنصر ( الإثارة ) المطلوبة.
إنّ القارئ لأيّة سورة قرآنية يحسّ، في حالة كونه جاداً ومتفاعلاً مع دلالاتها، بأنّ أثراً معيّناً قد تركته السورة في مجملها، دون أن يعي الأسرار الفنية وراء ذلك. علماً بأنّ ( الأثر ) المشار إليه يظل - في أحد مصاديقه أو في مقدّمتها - مرتبطاً بطبيعة ( الهيكل ) العام ( الكلّي )، بما تنتظمه من مواد وعناصر وطرائق تعبيرية تأخذ منحنيات الاستجابة البشرية بمختلف أشكالها بنظر الاعتبار، وهو أمر لا يتحقَّق بنحوه المطلوب، في حالة انفراط الأجزاء أو استقلالها، بل في تواشجها بعضاً مع الآخر على النحو الذي تقدّمت الإشارة إليه.
الفنّ وأشكاله...
الشِّعر:
تاريخياً يظلّ ( الشِعر ) أسبق الفنون اللفظية ظهوراً، بصفته - من حيث الدلالة النفسية للسلوك البشري بعامّة - تعبيراً عن نظام عصبي قائم على الاستجابة ( الموزونة ) للظواهر، فعملية ( التنفّس ) مثلاً، و( المشي )، وسائر النشاط الحركي، تظل ذات بُعد ( إيقاعي ) ملحوظ، لكل مَن حاولَ رصد السلوك الحركي للإنسان. من هنا، فإنّ المسوّغ إلى التماس تعبير عن حاجة ذات أصل ( حيوي )، يبرز قبل سواه من أشكال التعبير التي يَضْؤل ارتباطها بالأصول البيولوجية.
ويقول بعض مؤرّخي الفن - عِبر محاولاتهم تحديد نشأة الشِعر -: إنّ أول عملية إيقاعية وجِدت لها تعبيراً حركياً في نشاط الإنسان، هي: ( الدَّبْكَة )، ثمّ تطوّرت هذه العملية - وهي شاذّة في تصوّرنا الإسلامي - إلى نمط آخر من النشاط - وهذا أشدّ شذوذاً من سابقه - هو: الرقص.
وقد حاول المؤرّخون أن يربطوا بين شكلَي الإيقاع: ( الوزن، والقافية )، وبين الأنماط ( الحركية )، التي سبقت ظاهرة الشِعر بأشكال متنوّعة من مختلف مراحل التاريخ.
إنّ أمثلة هذا التفسير من الممكن أن تتسم بالصواب ولو بالقدر الضئيل منه، من حيث تحديدها لنشأة الشعر وجذوره الأُولى، إلاّ أنّها مؤشر إلى كون ( الإيقاع ) قد أُسيء استخدامه حينما استُثمر في نشاط شاذ مثل: الدبكة، أو الرقص. بَيْد أنّ أمثلة هذا التفسير التاريخي تبقى - من جانب - مرتبطة بالتفسير الأسطوري ل- ( أصل الأنواع ) وتطوّرها المزعوم، حيث انسحب تفسير هؤلاء المؤرِّخين لأصل الإنسان على تفسيرهم لأصل ( الفن ) أيضاً ؛ وذلك من خلال إخضاعهم مختلف الفنون ( من: شعر، وخطابة، ورواية، ومسرحية إلخ ) لنفس خطوات التطوّر الأسطوري.
والحقّ إنّنا لا نجد أنفسنا بحاجة إلى مناقشة أمثلة هذا التفسير الذي ابتُذل طوال ما يقرب من القرنين، مادام الزمن قد تجاوزه، ومادام أنصار النظرية المشار إليها يقرّون بكونها ( مذهباً عقلياً ) وليس ممارسة ( تجريبية )، ومادام - وهذا هو المعيار المهم - مضاداً للتصور الإسلامي حيال الأصل الإنساني والفني.
إنّ ما نعتزم توضيحه الآن هو أنّ الحركة ( الإيقاعية ) - بعامة - لا غبار عليها. كل ما في الأمر أنّ المشرّع الإسلامي أفرزَ نمطين منها: أحدهما يتصل بالاستجابة ( السوية ) للإيقاع، والآخر يتَّصل بالاستجابة ( الشاذّة ) حياله، فأقرّ النمط الأول منه وحرّم النمط الآخر.
إنّ قضية ( الإيقاع ) لا تنحصر في كونها مجرّد ( تنظيم ) صوتي، بل في طريقة ( التنظيم ) ذاته، من حيث صلتها بطبيعة استجابتنا العصبية حياله، وفقاً لِما هو ( سويّ ) أو ( شاذ ) من الاستجابة، وهو أمر نفصّل الحديث عنه عند معالجتنا لظاهرة ( الأغنية ) بعد قليل، إلاّ أنّنا هنا نعتزم مجرّد الإشارة إلى ( الإيقاع ) من حيث ارتباط الشعر به، مضافاً إلى ارتباطه بالعنصر ( العاطفي ) أيضاً، حيث يظل ( الإيقاع والانفعال ) في مقدّمة هذا الضرب من الفن، وهو أمر يستوقفنا لاستشفاف وجهة النظر الإسلامية حيال الفن المذكور.
من حيث البُعد التاريخي يبقى الشِعر - كما نعرف جميعاً - يحتلّ من آداب اللغة العربية مساحة كبيرة منه، بل هو ( ديوان ) هذه اللغة وسجلّ تاريخها، حتى إنّ القصيدة أو البيت - كما قيل - يُقعِد قبيلة ويقيم أخرى، ويُغيّر شريحة من شرائح التاريخ أيضاً.
وجاء الإسلام فأقرّ هذا الشكل الفني، بل شجّعه وثمّن مواقف الشعراء، ووعَدَ بالثواب، ومَنَحَ الهدايا، وأشار إلى تأثيره السحري في النفوس ؛... بَيْد أنّ الملاحظ أنّ الإسلام - في الآن ذاته - وقف ( متحفّظاً ) حيال الشعر، وهذا أمر يستوقف الباحث حقّ.
من الممكن أن يجيب البعض بسهولة: بأنّ الطائفة الأُولى من النصوص، أو الأفعال المثمّنة للشِعر، ناظرة إلى ( الشِعر الملتزم ) منه، وأنّ الطائفة المانعة عنه ناظرة إلى الشعر المنحرف مثلاً. بَيْد أنّه يمكن القول بأنّ قضيَّتَي الالتزام أو الانحراف لا تنحصران في فنّ الشعر فحسب، بل تنسحبان على مطلق الفنون ( الخطبة، الخاطرة، المقالة... إلخ ) فلماذا يتجه المنع أو الندب إلى الشِعر فحسب ؟
يضاف إلى ذلك: أنّ هناك طائفة ثالثة من النصوص ( تتحفّظ ) حتى حيال الشعر الملتزم إسلامياً، حيث تمنع من إنشاده في أزمنة وأمكنة خاصة، كما أنّ تنزّه النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم عن ذلك من خلال الآية الكريمة التي تقرّر بأنّه ( لا ينبغي له )، يعزِّز ( التحفّظ ) المذكور ؛ ممّا يعني أنّ هناك ( سرّاً ) وراء ممارسة الشعر مقترناً بما هو سلبي من السلوك، المصاحب للممارسة المذكورة.
إنّ المعنيّين بشئون الفن والتفسير والفقه، يحاولون تقديم أكثر من وجهة نظر في هذا الصدد، فنجد مَن يذهب إلى ( كراهة) الشعر جميعاً بين الأحاديث. ونجد مَن ينقل الظاهرة إلى إطارها التاريخي، فيحدّد المنع بما اقترن في الشِعر من الرقص والغناء ونحوهما. ونجد مَن قَرَنه بالتصوّرات التي كانت تُغلِّف المجتمع الإسلامي عصرئذٍ، في ذهابها إلى أنّ ( جنِّيَّاً ) يتكفّل بممارسة هذه المهمة على نحو ما هو مألوف في الأساطير الإغريقية عن ( أبولو ) مثلاً.
وفي هذا الاتجاه مَن يربط بين الكاهن والساحر والشاعر... إلخ.
وفي تصوّرنا أنّ هذه الأسباب مجتمعة ساهمت في ظاهرة ( التحفّظ ) الإسلامي حيال الشعر. بَيْد أنّ الأهم من ذلك هو: أنّ ارتكان الشعر أساساً إلى كونه استجابة ( انفعالية ) خارجة عن حدّ الاعتدال ؛ هو الأمر الذي يمكن أن نلتمسه تفسيراً للموقف الإسلامي ( المتحفّظ ) حيال الشعر.
إنّ تعامل أهل البيت (ع) في حقل ( الفن التشريعي )، أو في حقل الحياة العامة، يقتادنا إلى القناعة بأنّ مباركتهم للشعر، أو استشهادهم به، أو حتى إنشادهم أحياناً، يظلّ ناظراً إلى الشعر ( ليس من حيث كونه فنّاً )، بل من حيث كونه مجرّد أداة في التعبير عن الحقائق يتطلَّبها الموقف العابر، وإلاّ متى كانت ( الأراجيز ) - في المعارك مثلاً - تتوفَّر على صياغة خاصة تتطلبها التقنية الفنية ومعاييرها التي يرسمها نقّاد الشعر عصرئذٍ.
كما أنّ تعاملهم مع أكثر من شاعر، كان متّسماً بعدم إكساب الصوت أو الصورة أهمية ذات بال، بل إنّ أحد المواقف التي استشهد بها المعصوم (ع) ببيت شِعري ذات يوم لم يعنَ فيه بالوزن، حملَ أحد الأشخاص على أن ينتقد المعصوم (ع)، فأجابه (ع) بأنّه لا يعنيه ( الوزن )، بل تعنيه ( الدلالة ).
كما أنّ تعقيباتهم على قصائد الشعراء كانت منحصرة في ( الدلالة )، حيث طالبوا بتغيير بعض الأفكار، وطالبوا بإضافة أفكار أخرى، دون أن يتعرّضوا للجانب الفني من ذلك.
إنّ أمثلة هذه المواقف من أهل البيت تُعدّ مؤشراً واضحاً إلى أنّ تمثّلهم بالأبيات أو استماعهم أو تقويمهم، إنّما كان منصبّاً على القيَم الفكرية للشعر، وليس على قِيَمه الجمالية: من بُعد عاطفي أو تخيّلي أو إيقاعي، وهذا على العكس من عنايتهم (ع) بالصياغة النثرية، بخاصة صياغة ( الخطبة )، حيث نلحظ الفارق الكبير بين ( الخُطب ) التي توفّر النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم أو الأئمة (ع) على صِناعتها، وبين الشعر.
إنّ أبسط مقارنة - على سبيل المثال - بين خُطب نهج البلاغة وبين الشعر الذي أشرنا إلى تمثّلاتهم (ع) به، يدلّنا على مدى الفارقية الكبيرة بين نهج البلاغة من حيث قِيَمه الجمالية، وبين الشعر المشار إليه في افتقاده للقيَم المذكورة.
على أنّ عدم توفّر المعصومين (ع) على كتابة الشعر - بالقياس إلى النثر الفني - ينبغي ألاّ نحصره في كون ( النثر ) أيسر توصيلاً إلى الأذهان فحسب، بل نتجاوزه إلى أنّ الشعر، بصفته عملية ( انفعالية ) لا تتسم مع النضج الإنساني، هو المفسّر لغيابه عن ممارسات المعصوم (ع).
وقد سبق أن أوضحنا عند حديثنا عن عنصرَي ( التخيّل ) أو ( العاطفة )، كيف أنّ عدم مراعاتهما، من حيث الصلة ب- ( الواقع )، يفسد عمل الفن، ونضيف الآن: أنّ التركيبة النفسية للشاعر، وهو متميّز عن غيره بكونه يرث جهازاً فطرياً من الحسّ الإيقاعي يفتقده العادي من الناس، مصحوبة عادة باستجابة خاصة، هي: التعامل الإيقاعي والصوري مع الآخرين أيضاً، وليس مع التجربة الشعرية فحسب، ومثل هذا التعامل لا يتناسق مع ما ينبغي أن
تسلكه الشخصية الإسلامية من النضج الانفعالي في ممارساتها.
ومن الواضح أنّ الشخصية بقدر ما تسمح لجهازها الوراثي - وهو الحسّ الإيقاعي المتضخّم عند الشاعر - بالتحرّك وبممارسة هذا النشاط، يتضخّم الحسّ المذكور لديها، بحيث يسحب آثاره على استجابته الانفعالية حيال مطلق الظواهر.
من هنا ينبغي أن نضع فارقاً بين شاعر يصبّ جميع اهتماماته في تجربة الشعر، وبين آخر يستثمر الحسّ الإيقاعي لديه في تجارب شعرية محدودة، يمليها موقف عابر أو ضروري، كما لو افترضنا ذلك متمثِّلاً في دخوله لساحة القتال ( أراجيز وأناشيد عسكرية مثلاً )، أو تحريضه الجمهور عبر قضية مصيرية، أو استثارته للنفوس خلال تعبيره عن ضخامة الشدائد التي واجهها أهل البيت (ع).. إلخ.
إنّ أمثلة هذه المواقف تتطلّب التجربة الشعرية دون أدنى شك، إلاّ أنّها تتَّسم بكونها ( استثناء ) وليس ( قاعدة )، مع ملاحظة أنّ الاستثناء لا غبار عليه، بل قد يصبح ضرورياً. وبالمقابل فإنّ سلخ الاستثناء من طابعه، وجعله سلوكاً عاماً، يُفضي إلى وقوع الشخصية في وهدة الانحراف على تفاوت درجته.
وأيّاً كان الأمر، ففي ضوء الطابع الاستثنائي المذكور يمكن تفسير الموقف التشريعي حيال الشعر، من حيث مباركة المعصومين (ع) لبعض الشعراء، وإنشادهم للشعر، واستشهادهم به.
الشِعرُ والأُغنية
أشرنا إلى أنّ الشعر - تاريخياً - قد اقترن بظاهرة ( الغناء ) وغيره من الممارسات اللفظية والحركية التي رافقت الإنسان. وبما أنّ المشرّع الإسلامي قد حكمَ على ( الغناء ) بالحرمة ( وهي أعلى درجات الحظر )، حينئذٍ يتعيّن علينا الوقوف عند هذه الظاهرة ومعالجتها تفصيلاً، بخاصة أنّها تقترن - في تصوّر المنعزلين عن السماء - بإمتاع وتقبّل يسوِّغان مشروعية هذه الممارسة، وتجاوز ذلك إلى الزعم بفائدتها الملحوظة مثلاً.
طبيعياً ينبغي ملاحظة الفارق أولاً بين الشعر والغناء، فبالرغم من أنّ كليهما يخضعان لتنظيم صوتي وفق ( وحدات ) خاصّة، إلاّ أنّ عملية ( التقطيع ) للوحدات الصوتية المذكورة هي التي تفرز حدود كلّ منهما.
إنّ ( الشعر ): تنظيم صوتي يتألّف من وحدات لا يخلو تنظيمها من أحد شكلين، من الممكن أن يتمايزا إذا أخذنا بنظر الاعتبار بعض الفوارق بين الشعر العربي مثلاً وبين بعض أنماط الشعر الأُوربي، وهذان الشكلان هما: ( التفعيلة ) و( المقطع )، حيث يظلّ الأخير منهما جزء من التفعيلة، كما هو مقرّر في المبادئ العروضية.
ف- ( المقطع ): عيّنة مفردة، و( التفعيلة ): تركيب جملة من ( المقاطع )، فعبارة ( مسترشد ) مثلاً تقابِل بالرمز العروضي ( مستفعلن )، وإذا فككنا المركّب المذكور ( مسترشد - مستفعلن ) ورددناه إلى مجموعات جزئية، حينئذٍ تكون الجزئيات ثلاثاً هي: ( مس + تر + شد ) حيث يقابلها الرمز العروضي ( مس + تف + علن ).
أمّا إذا اتجهنا إلى العبارة النثرية مثلاً، حينئذٍ بمقدورنا أيضاً أن نقسّمها إلى عدّة مقاطع دون أن نخضعها بالضرورة إلى نظام التفعيلة، بل نخضعها إلى مجرّد ( النَّبْر - المقطع )، فعبارة ( مستوح ) مثلاً إذا فككناها إلى نظام ( النبر )، حينئذٍ تكون جزئياتها ثلاثاً هي: ( مس + تو + ح ).
ويهمّنا من هذا أن نشير إلى أنّ كلاً من نظام ( التفعيلة ) و( النبر )، إنّما يأخذان شكلاً شعرياً إذا أُتيح لهما أن يتكرّرا في ( وحدات ) صوتية ( منتظمة )، تتوالى وفق نسق هندسي واحد ( كما هو نظام الشعر العمودي )، أو نسق هندسي متفاوت ( كما هو نظام الشعر الحرّ ). بَيْد أنّ ما ينبغي لفت النظر إليه هو: أنّ مجرّد انتظام الصوت في ( وحدات ) خاصة
شعرياً لن تشمله ظاهرة ( الغناء )، إلاّ أنّ الظاهرة تقترب من تخوم الغناء.
حينما نواجه نظام ( النبر ) وإخضاع وحداته الصوتية إلى تنظيم خاص، يلعب فيه كل من ( المدّ ) و( التفخيم ) و( التقصير ) للأصوات دوراً كبيراً في تشكيل مصطلح ( الغناء )، حيث يمكن إخضاع القصيدة مثلاً - أو عدم إخضاعها - للدور المذكور، وذلك حسب تقطيعنا الصوتي في القراءة.
والحقّ لا يمكننا أن نُقدّم للقارئ تحديداً خاصاً لعمليات ( المدّ، والتفخيم، والتقصير ) في الأصوات، لكي نفرزها عن سواها من التنظيمات الصوتية التي تندرج ضمن الغناء ؛ والسّر في ذلك يعود إلى طبيعة استجابتنا العصبية للصوت، فالأعصاب ( المورِدة ) للمثير الصوتي و( المصدّرة ) لذلك، إنّما تحّددها استجابة غامضة يرافقها ( شذوذ )، أو حالة غير طبيعية يتحسّسها المستجيب ويميّزها عن غيرها من الاستجابة الطبيعية ( السَّويَّة ).
من هنا تركَ المشرّع الإسلامي تحديد ( الغناء ) وأوكله إلينا ؛ بصفة أنّ عمليات ( المدّ، والتقصير، والتفخيم ) تندّ عن الوصف، ولا يمكن إخضاعها لعمل تجريبي، بل إنّه قدّم نماذج مألوفة جاء بعضها في سياق زمني خاص، وبعضها مطلقاً، فمثلاً تطالعنا بعض النصوص المأثورة عن أهل البيت (ع) فيما تمنع قراءة القرآن الكريم ب- ( ألحان ) غير العرب.، ولكن ما هي ألحان العرب مثلاً ؟ ذلك أمر لا يمكن تحديده تجريبي، لكنّنا إذا عدنا إلى المؤرّخين لحظنا أنّهم يشيرون إلى أنّ ( ألحاناً ) شتّى دخلت البلاد الإسلامية بعد الفتح، وإلى أنّها لم تنسجم مع الألحان المألوفة محلّياً، وهو أمر لا يمكن معرفته إلاّ لِمن أُتيح له عصرئذٍ أن يخبر بنفسه الألحان ( العربية ) ويميّزها عن الألحان المألوفة.
وهناك نموذج آخر قدّمته نصوص التشريع وحكمت عليه ب- ( التحريم ) أيضاً، ولكنّه غير مقترن بجهاز النطق، بل بمجرّد ( الصوت المنتظم )، وهذا من نحو استخدام ( الناي ) مثلاً وسواه من أدوات ( العزف )، حيث جاءت مصطلحات: ( المعزف ) و( المزمار ) و( العود ) في لسان النصوص الإسلامية التي حرّمت استخدامها.
بالمقابل قدّمت النصوص الإسلامية بعض التشكيلات الصوتية ( المباحة )، بل ( المندوبة )، مثل ( الترتيل ) في القراءة والأذان، و( الحدر ) في الإقامة مثلاً.
إنّ نصوص التشريع الإسلامي، حينما تُقدّم لنا نماذج من التشكيلات الصوتية المباحة والمندوبة والمحرّمة، إنّما تترك لنا تحديد ذلك في ضوء معرفتنا بالاستجابة العصبية لصوت لا يُخرج الإنسان عن التوازن العصبي المألوف، وهذا أمر يمكن فرزه بسهولة، وإن كان ( تجريبياً ) ممتنعاً كل الامتناع.
ويمكننا مقارنة ذلك بحالة خاصة تنتابنا حينما نُغمر بفرح غير طبيعي عند سماعنا لنبأ سعيد، أو رؤيتنا لجمال مدهش، حيث نفقد توازننا الطبيعي ونسمح لخيالنا بممارسة خبرات ملتوية نستحضرها في الذهن، متصلة بما هو مكبوت في أعماقنا، بخاصة الخبرات الجنسية التي يرتبط بها الغناء بنحو لا نعيه شعورياً، ممّا يُخرجنا من نطاق المشاعر الموضوعية.
وهناك من النصوص الإسلامية ما يشير إلى أمثلة هذه الاستجابة الشاذّة للغناء، أو ما يقترن بذلك من آثار نزعات وميول مرضية، ومنها: ظاهرة( القسوة ) ، وظاهرة( النفاق ) .
وقد ورد عن الإمام الباقر والصادق والرضاعليهمالسلام في تفسيرهم للآية الكريمة:( وَمِنَ النّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلّ عَن سَبِيلِ اللّهِ ) ، أنّهم (ع) قالوا: ( منه الغناء ) أي أنّ الغناء من اللهو الذي يضلّ عن سبيل الله.، وتعرّضوا (ع) إلى كل من ( اللهو ) و( الغناء )، مشيرين إلى كونهما يتسبّبان في إنماء النزعة العدوانية عند الشخصية، حيث أشار النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم والصادق (ع) إلى ظاهرتين من العدوان هما: القسوة، والنفاق، مثل قولهصلىاللهعليهوآلهوسلم : ( ثلاثة يُقسين القلب: استماع اللهو،...)، ومثل قول الصادق (ع): ( استماع اللهو والغناء يُنبت النفاق كما يُنبت الماء الزرع )، وورد أيضاً قوله (ع): ( ضربُ العيدان يُنبت النفاق في القلب ).
هذه النصوص الثلاثة تُفصح عن جملة من الحقائق النفسية متمثِّلة في أنّ كلاً من ممارسة الغناء والاستماع إليه، أو ممارسة الصوت الخالص والاستماع إليه من خلال أدواته الموسيقية، تستتلي الوقوع في براثن الانحراف النفسي والفكري متجسّداً في ظاهرتَي: ( القسوة )، و( النفاق ).
إنّ معجم ( علم النفس المرضي ) - ومنه الأمراض السكوباثية - يشير بوضوح إلى خطورة ( القسوة ) عند الشخصية، وما تفرزه من أنماط عدوانية في السلوك بالغة المدى. كما أنّ ظاهرة ( النفاق ) تجسّد بدورها واحداً من طوابع الشخصية (المنحرفة) المشار إليها، حيث تتعامل بلغة ( النفع الخالص ) مع الآخرين، وليس بلغة ( الإنسان ) في عاطفته التي تفرزه عن العضويات الأخرى، حتى إنّ الإمام علياً (ع) في تقسيمه المعروف للأمراض النفسية، وصلتها بالانحراف الفكري ( الكفر والنفاق )، أرجعَ نصف السلوك المرضي إلى ظاهرة ( النفاق )، حيث أدرجَ ضمنها جملة من مفردات السلوك المنتسبة إليه.
إذاً ثمّة أسرار نفسية - وعضوية أيضاً - تظل على صلة بممارسة ( الغناء ) و( الموسيقى ) فيما أشار المشرّع الإسلامي إلى ذلك كما لحظنا، فضلاً عن إشارة الطّب الأرضي إليها أيضاً، حيث ألمحَ الطب الجسمي إلى صلة ارتفاع الدم وانخفاضه بحدّة التشكيلات الصوتية وهدوئها، كما ألمحَ الطب النفسي والعقلي إلى ظاهرة ( الإعياء العصبي والنفسي ) وصلته بالتشكيلات المذكورة، ممّا يعني أنّ ممارسة ( الغناء ) و( الموسيقى )، حيث خُيّل للبعض أنّهما يساهمان في تفجير المتعة للشخصية، تظل على العكس ممّا هو متخيّل، تماماً بمثل التصوّر الخاطئ للمخدّرات التي تحفر في أعصاب الشخصية آثاراً بالغة الضرر ( نفسياً وعقلياً وجسمياً ) ثمناً لمتعة عابرة.
المهم أنّ تنظيم الأصوات وفق مدّ وتفخيم وتقصير خاص ( الغناء والموسيقى )، يظل على صلة باستجابة عصبية شاذّة عبر عملية توريد المثير الصوتي وتصديره، فيما تُخرج العملية المذكورة الإنسان عن نظامه العصبي الذي ركّبته السماء وفق طاقة محدّدة من الاستجابة العادية، حيث يقتاد تجاوزها
إلى خلخلة النظام العصبي من جانب، وما تستجرّه من عمليات نفسية من جانب آخر، بما يواكب ذلك من تفجير وإنماء لميول وخبرات جنسية وعدوانية وانحرافية عامة، أشارت إليها توصيات السماء والأرض بالنحو الذي تقدّم الحديث عنه.
الشِعرُ والتجربة الجنسية
بالرغم من أنّ التجربة الجنسية - التي أشرنا إلى ارتباط بعض التشكيلات الصوتية بها - لا تخصّ شكلاً فنياً دون غيره، إلاّ أنّها اقترنت - في تاريخ الشعر - بأحد اتجاهات( التشبيب ) ، وإلاّ فإنّ القصة أو المسرحية أو أي شكل فنّي، يظل موسوماً بنفس تجارب الجنس، بصفته واحداً من الموضوعات التي تشترك جميع الأشكال الفنية في تناولها.
إنّ التصوّر الإسلامي للجنس يحصر مشروعيته في ممارسة واحدة هي: الزواج، بكل ما يواكبه من سلوك رسمته الشريعة الإسلامية فيما لا يخصّ دراستنا الآن،... يعنينا من ذلك تمرير هذه التجربة من خلال ( الفن ) فحسب.
ومعلوم أنّ التجربة الجنسية شيء، وتجسيدها في عمل ( فني ) شيء آخر، فالفن - في بعض مستوياته -: اصطناع لتجربة ذهنية صرف، لا علاقة لها بأعمال الفنان، بمعنى أنّ الفن لا يجسّد تعبيراً حقيقياً عن أعمال كاتبه، بل هو عمل ذهني قد يعبّر حيناً عن ( معاناة ) حقيقية وقد لا يعبّر عن ذلك. ولعلّ الشعر العربي الموروث - على سبيل المثال - مظهر واضح للحقيقة المتقدّمة، حيث تستهلّ القصائد تجربتها بأفكار جنسية مصطنعة تمثل مجرّد ( تقليد ) فنّي لا أكثر.
والسؤال هو : هل أنّ التعبير عن الأفكار الجنسية - يلتئم مع التصور الإسلامي لهذا الدافع أم لا ؟
بعض الفقهاء - على سبيل المثال - في معرض حديثهم عن المكاسب المحرّمة، يتناولون تجربة الجنس من خلال الغزل أو التشبيب، حيث يعرضون الأدلّة المبيحة أو المتحفّظة أو المانعة من ممارسة ذلك.
إلاّ أنّ تصوّرنا حيال ذلك هو: أنّ الفن - سواء كان تعبيراً مصطنعاً عن أفكار صاحبه، أم كان تعبيراً حقيقياً عنها - لابدّ أن نعرضه في ضوء التصوّر الإسلامي لقضية الجنس، من حيث مشروعية إبراز تجربته ( لفظياً ) إلى الآخرين. فإذا قلنا بأنّ ( الغزل ) أو ( التشبيب ) إسلامياً لا غبار عليه، حينئذٍ لا غبار على تجسيده ( فنياً ) أيضاً، وأمّا إذا قلنا بأنّ ذلك لا يلتئم من الخط الإسلامي، حينئذٍ فلابدّ أن ينسحب ذلك على ( الفن ) أيضاً.
طبيعياً لا يعنينا أن نحدّد درجة الحظر التشريعي أو الجواز، من حيث درجتهما ( حرمة أو كراهة ) و( وجوباً أو ندباً )، بل يعنينا عرض التصوّر الإسلامي لمطلق الحظر أو الجواز، وحتى ما يصطلح عليه ب- ( المباح )، نحاول النظر إليه، بأنّه داخل في دائرة ( التحفّظ ) طالما نحرص على الالتزام بما هو ( أفضل ) من السلوك، بحيث يتحوّل ما هو ( مباح ) إلى ما هو ( مندوب) مادام ذلك مقترناً بما هو ( أحبّ إلى الله تعالى ).
المهم : هل أنّ نقل التجربة الجنسية من صعيد ( الواقع ) - حتى لو كان مشروعاً مثل الممارسات الزوجية - إلى صعيد (الفن) يلتئم مع الخط الإسلامي ( بغضّ النظر عن كونه محرّماً، أو مكروهاً، أو حتى مباحاً ) ؟
ونجيب:
مادام الإسلام لا يسمح - أولاً - بأيّة ممارسة جنسية خارج أُطر الزواج، حينئذٍ فأيّة ممارسة، سواء أكانت نقلاً لتجربة مشروعة، أم كانت مجرّد ( غزل ) مصطنع أم حقيقي، تظلّ ( محظورة ) أيضاً دون أدنى شك.
لقد مَنعَنا الإسلام من النظر إلى ( المرأة )، ومنعنا من التحدّث معها إلاّ لضرورة، ومنعنا ( ممازحتها )، ومنعنا من ( التخيّل الجنسي ) أي: أحلام اليقظة وما يتصل بها من الفاعليات الأخرى. كما منع المرأة بدورها من النظر إلى الرجل، ومنعها من إظهار زينتها... إلخ.
مضافاً إلى ذلك - وهذا ما نود التأكيد عليه الآن -: قد منعها من نقل تجاربها الجنسية - بما يواكبها من ممارسات تخص الزوجين - إلى الآخرين، مثلما منع الرجل من أن ينقل مفاتن المرأة إلى الآخرين، حتى إنّ النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: ( مَن وصفَ امرأة فافتُتن بها، لم يخرج من الدنيا إلاّ مغضوباً عليه... ).
والآن ماذا نستخلص من هذا النص ؟
إنّ أبسط تأمّل في هذا الصدد يقتادنا إلى قناعة كاملة بأنّ الإثارة الجنسية - أيّاً كان شكلها - ينبغي ( التحفّظ ) حيالها، إنّ الشاعر الذي ( يتغزّل ) بالمرأة - سواء أكانت زوجته، أم كانت ( مبهمة ) لا يعرفها أحد، أم كانت ( وهمية ) لا حقيقة لها - تظل موضع ( إثارة ) دون أدنى شك، فالمشرّع الإسلامي عندما منعَ المرأة من أن تنقل لصاحبتها تجربتها مع الزوج، أو عندما منعَ الرجل من أن يصف المرأة لأحد الرجال - كما هو صريح الرواية المتقدّمة - إنّما كان صريحاً في إدانة هذا العمل، حتى إنّه وسمَ مثل هذا الشخص بأنّه ( لم يخرج من الدنيا إلاّ مغضوباً عليه ).
حينئذٍ كيف يسمح الشاعر أو القاص لنفسه بأن ينقل ( مفاتن المرأة ) إلى القرّاء، ثمّ لا نتوقّع إثارتهم، ما هو الفارق بين رجل يصف مفاتن المرأة للآخرين بشكل عادي، وبين نقله ذلك من خلال الفن ؟
وممّا يزيد الأمر غرابة: أن نجد كُتّاباً إسلاميين ينقلون في قصصهم أو قصائدهم تجارب ( الحبّ ) تحت ستار مشروعيته، أو حتى بصفته ( مقدّمة ) زواج مثلاً، بل إنّ بعضهم يجعل ( حبكة ) القصة أو
( عقدتها ) قائمة على تجربة ( حبّ إسلامي )، بالنحو الذي يبتعث الإثارة التي أشار النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم إلى أنّ صاحبها لم يخرج من الدنيا إلاّ مغضوباً عليه.
إنّ النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم ( في نصّ آخر ) سُئل عن العشق والعشّاق، فقال بما مؤدّاه:( قلوب خَلت من محبّة الله فابتلاها بحبّ غيره ) ، وهذا يعني أنّ قضية الجنس، سواء أكانت تعبيراً عن صاحبها الذي يُعنى بمعايشتها ( حتى لو لم ينقلها إلى الآخرين )، أو تعبيراً مطلقاً لكنّه يتسبّب في إثارة الآخرين من خلال نقلها، كل أولئك يظل محظوراً في التصوّر الإسلامي لهذا الجانب. كما يعني أنّ تجربة الجنس ينبغي أن تظلّ سجينة داخل أسوار ( الحياة الزوجية )، لا تتجاوز طرفَي العلاقة.
قد يعترض قائل ( كما افترض بعض الإسلاميين ذلك ) فيقرّر: إنّ نقل التجربة الجنسية مادامت لا تؤشِّر إلى امرأة بعينها فلا مانع من ذلك، بعكس ما إذا كانت معروفة لدى القارئ، حيث يستلزم ذلك تشويه سمعتها، فيجيء المنع من جهة ( التشهير )، وليس من تجربة النقل.
والحقّ أنّ ( التشهير ) وعدمه مسألة مستقلّة لا تنحصر في عمل فني أو عادي، كما أنّ المعيار ليس هو تعريف المرأة أو تنكيرها، بل مشروعية ( الغزل ) أو عدمها، فما دام نقل التجربة إلى الآخرين يتسبّب ( الإثارة ) كما قرّر النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم ذلك، حينئذٍ يظلّ محكوماً بطابع المنع إسلامياً.
مضافاً لِما تقدّم، ثمّة حقيقة بالغة الأهمية إلاّ أنّها غائبة تماماً عن الأذهان، وهي: أنّ العمل الفني القائم على تجربة الجنس، يظل موسوماً بصفة ( العبث ) في حالة افتراضنا عدم حظره شرعياً، فمعَ مثل هذا الافتراض، وهو لا حقيقة له كما أشرنا، نتساءل: ما هي الفائدة العبادية لهذا العمل ؟ أليس الكاتب الإسلامي مطالباً بألاّ يمارِس إلاّ العمل الفني ( الهادف ) ؟ ما هو الهدف الذي ننشده من وراء عرض ( المفاتن والعواطف الجنسية ) ؟ هل نستهدف من ذلك ( تزجية فراغ ) ؟ الإسلام لا يقرّنا على ذلك.
هل نستهدف منه شدّ الآخرين إلى ممارسة هذا السلوك لاستثماره في عمل عبادي آخر ؟ أو التشجيع على المسارعة بالزواج لمعايشة المفاتن والعواطف ؟
الإسلام لا يقرّنا على ذلك أيضاً، بل يرسم لنا طرائق أخرى لتحقيق هذه المهمة، من خلال التوصيات التي تحثّ على الزواج ومهمته البيولوجية والتناسلية.
إذاً لا مسوّغ على الإطلاق لممارسة سلوك فني ( محظور شرعاً )، أو لا أقل لا فائدة فيه، في حين أنّ الإسلام يطالبنا بعمل جاد هادف، ويحذّرنا من كل أشكال اللهو والعبث أو الفراغ، أو مطلق السلوك الذي لا يحقّق غرضاً عبادياً بالنحو الذي أشرنا إليه.
القصّة والمسرحية
القصة - في أوسع دلالاتها -: عمل فني قائم على بناء هندسي خاص، ( يصطنع ) كاتبها واحداً أو جملة من الأحداث والمواقف والأبطال والبيئات، عبر لغة ( السرد ) أو ( الحوار ) أو كليهما، وتتضمّن ( هدفاً ) فكرياً محدّداً، يُخضع الكاتب عناصره إلى دائرة ما هو ( ممكن ) أو ( محتمل ) من السلوك، كما يمكن إخضاعها لِما هو ( ممتنع ) من السلوك، إلاّ أنّه يتضمّن ( رمزاً ) يحوم على ( الهدف ) الفكري المشار إليه،... كل ذلك وفق عملية ( اصطفاء ) خاصة للعناصر المذكورة.
هذا النمط من العمل الفني قد يكون عملاً ( مقروءاً ) يطلق عليه مصطلح ( القصة )، بمختلف أشكالها: حكاية، أقصوصة، قصة قصيرة، رواية... إلخ. وقد يكون هذا العمل ( مُشاهَداً ) يطلق عليه مصطلح ( المسرحية )، مع ملاحظة الفوارق بينها وبين القصة، من حيث بنائهما وعناصرهما ممّا لا يعنينا الآن أن نعرض لهما.
يعنينا فقط أن نعرض الآن للتصوّر الإسلامي حيالهما، بصفتهما نمطاً من الممارسة الفنية القائمة على ما هو ( متخيّل ) أو ( وهمي ) من السلوك، وليس على ما هو عملي أو واقعي منه، مع ملاحظة الفارق بين عمل تخيّلي مثل الشعر، من حيث كونه يعتمد التخيّل بمثابة ( عنصر ) مساهِم في تجلية الدلالة، بينا تعتمد القصة والتخيّل ( أرضية ) لها وليس مجرّد عنصر. فضلاً عن أنّ التخيّل الشِعري هو إحداث علاقة بين الأشياء ( عنصر الصورة )، بينا تظلّ القصة ( خَلقاً ) لأشياء، وليس لعلاقة بين أشياء، ممّا يسوّغ طرح مثل هذا السؤال القائل: ( هل أنّ الإسلام يقرّ تعاملنا مع الظواهر ( المختلفة ) أساساً، أم أنّ إقراره منحصر في إحداث ( العلاقة ) بين الظواهر، كما هو شأن ( الصورة الفنية ) مثلاً ؟
تاريخياً لم ينشط العمل القصصي ( بشكليه: الروائي والمسرحي ) في مناخ الرسالة الإسلامية، ولا قبله أيضاً. ويحاول مؤرّخو الأدب أن يلتمسوا جملة من الأسباب الكامنة وراء ذلك ؛ مثل ذهاب البعض إلى أنّ الخيال العربي متّسم بالمحدودية بالقياس إلى غيره، بصفة أنّ العمل القصصي قائم في أساسه على عملية تخيّل للأحداث والمواقف والأبطال والبيئات، ممّا لا تسمح الصحراء القاحلة بتنشيطه في العمليات الذهنية.
وهناك مَن يذهب إلى أنّ القرن الثاني الهجري قد خبر الشكل القصصي عبر الترجمة التي توفرت لعلوم الأغارقة واليونانيين والفرس والهنود، إلاّ إنّ الطابع ( الوثني ) الذي يسم الفن المذكور وقف حاجزاً عن الاستجابة له.
وأياً كان السبب، فإن ما يعنينا هو إنّ المشرع الإسلامي لم يتعرض لهذا الفنّ: رفضاً أو تقبُّلاً أو تحفُّظاً، إلاّ بعض الإشارات العابرة التي يمكن إخضاعها لتأويل أو آخر. بَيْد أنّ الملاحظ - وهذا هو موضع الأهمية - أنّ النص القرآني الكريم توفّر على العنصر القصصي بنحو لافت كل اللفت للانتباه.
لكن: هل أنّ القصص القرآني مماثل للقصص الأرضي المشار إليه ؟
إنّ التقنية القصصية من الممكن إنّ تتماثل - مع ملاحظة التميُّز من جانب، والفارق الإعجازي من جانب آخر بطبيعة الحال - لدى كل من القصة القرآنية والأرضية، من حيث أدوات البناء وعناصره. إلاّ إنّ الفارق الكبير بينهما هو إنّ القصة القرآنية تتعامل مع (واقع تاريخي)، بينما تتعامل القصة البشرية مع ( واقع مصطنع أو وهمي)، والفارق بينهما بمكان كبير من حيث مسوِّغات الفن.
وبالرغم من أنّ هناك واحداً من أشكال القصة يعرف ب- ( القصة التاريخية )، تتعامل في بعض أنماطها مع ( الواقع التاريخي ) فيما تعرض لأحداث وقعت فعلاً، إلاّ أنها - كما نعرف ذلك - تبقى موشاة بوقائع ( مختلَقة ) أيضاً، ممَّا يخرجها من نطاق حرْفية الواقع.
إنّ معرفتنا بالخطوط العامة لجوهر التشريع الإسلامي، من حيث مطالبته عموماً بأن نتعامل مع الواقع وليس مع اختلاقه، ومعرفتنا بأنّ عملية ( القص ) قد اقترنت ببعض الحظر: مثل ما ورد عن النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم من ذهابه إلى إنّ القاص ممقوت ؛ نظراً لِمَا يصدر عنه من نقيصة أو زيادة في النقل، ومثل ما ورد عن الإمام علي (ع) من أنّه طرد بعض القصَّاص من المسجد....
مضافاً إلى إنّ ( الكذب ) ممقوت أساساً: والقص بعض نماذجه مثلاً.
فضلاً عن أنّ القرآن الكريم لم يعرض إلاّ القصص العملي، أي القصص الذي وقع فعلاً، دون إنّ يتجه إلى اختلاق ذلك.
أولئك جميعاً تجعلنا ( نتحفَّظ ) في إمكانية إنّ يسمح الإسلام بممارسة القصص المختلفة.
لكن بالرغم من ( التحفُّظ ) المذكور، من الممكن أنّ يجاب على ذلك، بأنّ التعامل مع الواقع لا يمنع من إمكانية التعامل مع ما هو ( مختلَق ) إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنّ القصة مجرد ( افتراض ) لواقعة أو موقف، يقرّ بافتراضه طرفان هما ( القاص والقارئ )، بمعنى أنّ كلاًّ منهما مدرك بأنّه حيال ( عمل مختلق )، يكون بمثابة اتفاق ضمني بين الكاتب الذي يقدِّم لقارئه مادة فنية يتقبَّلها القارئ على أنَّها مصطنعة، تستهدف إيصال بعض الحقائق لا أكثر.
ومع هذا ( العقد ) بين الكاتب والقارئ، تنتفي الملاحظة القائلة بأنّ القصة تتعامل مع الوهم، كما ينتفي طابع ( الكذب) عنها إذا أدركنا أنّ مجرد ( الافتراض ) لشيء ما لا يُدعى ( كذباً )، بل يدعى ( افتراضاً ). فإذا قال أحدهم: ( افترض أنّ
حادثة قتل وقعت لمجموعة من الأشخاص، وأنَّ الجُناة مَثَلوا أمام القضاء، فحكم عليهم بالإعدام )... مثل هذا القص عن حادثة القتل ( المفترضة ) لا غبار عليها ما دام الكاتب والقارئ على إحاطة بأنّ الحادثة المذكورة مجرد افتراض، بدليل قوله ( افترض... إلخ )، وأنَّ ذلك صيغ من أجل هدف خاص، هو التنبيه على أنّ ممارسة القتل سوف لا تمرّ على أحد من دون قصاص مثلاً.
وأمّا ما ورد عن النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم من أنّه وسم القاص بأنّه ( ممقوت ) ؛ نظراً لِمَا يزيد إو ينقص في كلامه، فإنَّ ذلك لا علاقة له بعملية ( الفن القصصي )، بل بالقصة الواقعية نفسها ؛ حيث يعرض الشخص لحادثة أو لقصة تاريخية دون أنّ يكون متأكِّداً في نقلها، بل يزيد أو ينقص فيها إمّا عمداً أو نسياناً أو عدم تقيُّد بها، وهو أمر ينسحب على نقل الحديث بعامة، دون أنّ تكون له صلة بالعمل الفني كما هو واضح.
وأمّا ما ورد عن الإمام علي (ع) من أنّه طرد بعض القُصَّاص من المسجد، فمن الممكن أنّ يستند الطرد إلى قدسية المسجد وليس إلى عملية ( القص )، حيث ورد النهي عن انشاد الشعر في المسجد أيضاً، وورد النهي - في سياقات خاصة - عن ( النوم ) في المسجد، أو ( البيع ) فيه أيضاً، وهو أمر لا علاقة له بمشروعية الشعر أو النوم أو البيع، بل بقدسية المسجد الذي ينبغي إنّ يتمحّض للعمل العبادي، وليس لتحقيق الراحة أو المال أو سائر أشكال الإمتاع النفسي والجسمي. هذا فضلاً عن أنّ القاص عصرئذٍ - كما يذكر المؤرِّخون - كان نشاطه مغايراً لِمَا تستهدفه ( القصة الفنية ) من أفكار، حيث كان بعض المرتزقة يحترف القص لاستدرار المال، فيفتعل قصصاً مثيرة من أجل تسلية المستمع وتزجية الفراغ مقابل الفائدة المالية أو الاجتماعية التي يحصل القاص عليها، بخاصة أنّ هناك من الأشخاص - مضافاً للنمط الذي أشرنا إليه - مَن يختلق ( القصة ) كي يلتمس له ( مجداً ) في الجاهلية مثلاً، أو مطلق الأمجاد الزائفة التي كانوا يعنون بها عصرئذٍ.
إذاً من الممكن إلاّ يقترن مع العمل القصصي - بصفته فنّاً - أي محذور شرعي في ضوء الاعتبارات التي أشرنا إليها. والأمر نفسه بالنسبة إلى ( العمل المسرحي ) أيضاً، مادام ( التمثيل ) أو ( التجسيد )، يظل بديلاً عن الكلمة لا غير، حيث يمكن مقارنة ذلك بعملية ( وضوء ) مثلاً يصطنعها شخص مستهدفاً من ذلك تعليم الآخرين لعملية الوضوء المذكورة.
* * *
هنا ينبغي أنّ نقرِّر إلى أنّه بالرغم من عدم ترتب محذور إسلامي من كتابة القصة أو المسرحية في ضوء الاختلاق لظواهر الواقع، إلاّ أنّ المؤكَّد بأنّ التعامل مع الظواهر بنحوها ( الفعلي ) - كما هو شأن القصة القرآنية - يظل أمراً لا غبار عليه ألبتة، كما أنّه يجنِّبنا أي احتمال سلبي نتوقعه حيال كتابة ما هو مصطنع أو وهمي من الظواهر.
إنّه من الممكن حقاً أن نوفّر للقارئ قسطاً من الإمتاع الجمالي من خلال انتقائنا شرائح
معينة من الحياة الفعلية وصياغتها وفق بناء عماري خاص، على نسق ما نلحظه من القصص القرآني حيثِ ينتخب في سورة ما أحداثاً ومواقف لأحد الأبطال، وينتخب أحداثاً ومواقف غيرها للبطل نفسه في سورة أخرى: حسب ما يستدعيه سياق السورة.
إنّ انتخاب حدث أو موقف من إحداث ومواقف الثورة الإسلامية مثلاً وسواها، من الممكن أن نقتطع منها ما يتواسق و(وجهه النظر ) التي نستهدفها ونحرص على إبراز مضمونها الإسلامي، حيث نصوغها في ضوء اللغة القصصية التي تنتخب من الحادثة والبطل ما يتجانس مع أدوات الحوار والسرد، وما يواكبها من عمليات التقطيع والاختزال والتكثيف... إلخ.
إنّ القصة تتميَّز بكونها أشد لصوقا بواقع التركيبة البشرية عن سائر أشكال الفن، فالدافع إلى الاستطلاع مثلاً، وطريقة الاستجابة للشيء، تجعلان القصة أشد إثارة من غيرها للنفوس، بخاصة أنّ رصد حركة الآدميين تظل هي التجسيد الحيّ لحركة القارئ نفسه.
وحيال ذلك، فإنّ عملية الرصد لِمَا هو ( فعلي )، يكتسب قدراً من الإثارة أشد ممَّا هو ( محتمل الوقوع)، فالقارئ أو الملاحظ حين يتابع قراءة قصة ( مصطنعة )، بما تنطوي عليه من عناصر الإثارة تشويقاً ومماطلةً ونحوهما، يظل انفعال هذا القارئ أو الملاحظ ( فنياً ) أكثر منه ( وجدانياً)، بمعنى أنّ انفعاله بمضمون القصة ( وهمي )، لا يترك فاعلية ذات أثر إلاّ في حينه، ما دام سلفاً على إحاطة كاملة بأنّه حيال أحداث ( وهمية ) يفتعلها القاص. وهذا بخلاف ما لو علم أنّه حيال حدث فعلي، حينئذٍ فإنَّ انفعاله بالحدث سيكتسب سمة ( الفعلية ) أيضاً، بحيث يترك فاعليته في النفس ويسحب آثاره على عمليات ( التعديل ) للسلوك، حيث تظل عمليات ( التعديل ) هي الهدف من وراء العمل الفني كما هو واضح.
يضاف إلى ذلك أنّ تدريب الشخصية على أنّ تتعامل مع الواقع، يقتادها إلى النضج الانفعالي وتماسك بنائها، على العكس من تدريبها على التغذية من ( الوهم )، حيث يسحب ذلك أثره على بنائها العقلي والنفسي، ومن ثمّ يرشِّحها للوقوع في وهدة الشذوذ الذي يفصلها عن أرض الواقع ويدعها نهباً للخيالات والأوهام والوساوس.
إذاً أنّ ما يتّسق مع التصور الإسلامي للسلوك هو: أن ( يلتزم ) القاص الإسلامي بصياغة العمل الفني المرتكن إلى الواقع الفعلي كما هو طابع القصة القرآنية الكريمة، بخاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنّ ( فعل ) و( ممارسة ) ما يتصل بالحقل التشريعي يظل هو النموذج الأمثل لسلوكنا الذي ينبغي أن نصدر عنه، أي: أنَّ مبادئ الفنّ الشرعي - وهو ما نلحظه في الكتاب والسنّة - ينبغي أن تظل النموذج لسلوكنا الفني أيضاً، بالنحو الذي أكَّدناه عند حديثنا عن عناصر الفن في الصفحات السابقة من هذه الدراسة.
إنّ القاص الإسلامي ينبغي إنّ يصوغ له اتجاهاً قصصياً يتميَّز به ويتفرَّد بممارسته، بحيث
يصبح اتجاهاً خاصاً به، مثال الاتجاهات الأرضية في ضوء التميّز الذي يطبع رسالة الإسلام ذاتها.
القاص الإسلامي بدلاً من أن يبذل جهداً فكرياً يتطلّبه انتقاء الحديث والشخصية والموقف (المفتعل)، بدلاً من ذلك، يمكنه أن يبذل الجهد ذاته في انتقاء ما هو (واقع) من الظواهر، وانتقاء ما هو مثير من حوار الأبطال مثلاً، أو ما هو مثير من جزئيات الحوادث المواقف: من حيث طريقة تقطيعها وتوصيلها، وطريقة تعامله مع (الزمن)، من حيث توحيده وتذويبه وفقاً للنمو النفسي أو لنموه الموضوعي حسب ما يستدعيه السياق.
طبيعياً أنَّ الحرص على تسجيل وقائع (فعلية) وما يواكبها من المواقف، لا يمكن أن يتم بسهولة إذا أخذنا بنظر الاعتبار صعوبة رصد العمليات الذهنية بالقياس إلى رصد الأحداث، التي يمكن أن ينتقي منها ما يتواسق ووجهة النظر التي يستهدفها القاص، على العكس من العمليات الذهنية التي لا يمكن تسجيلها البتة إلاّ من خلال النقل المباشر من لسان الأبطال أنفسهم.
فالقصة القرآنية - مثلاً - عندما تنقل لنا أفكار البطل، إنَّما ترتكن إلى كون الله تعالى (عالماً) بما في الصدور، بخلاف القاص الذي لا يمكنه معرفة أعماق الآخرين إلاّ إذا كشفوا هم أنفسهم عمّا تحمله أعماقهم من الأفكار والعواطف والاتجاهات. ولذلك من الممكن التغلّب على هذه الصعوبة من خلال إحدى الوسائل التي تعرض لها، فمثلاً يمكن للقاص أن يدخل إلى أعماق البطل مباشرة، على نحو ما يفعله الخبير أو المرشد النفسي الذي يعقد لقاء مباشراً مع الأشخاص، ثمَّ يبدأ بتسجيل كل ما يتحدَّثون به، موجهاً إليهم مختلف الأمثلة، حيث ينتخب من هذه الإجابات ما يتساوق مع (الهدف الفكري) الذي يريد إبرازه من القصة، ويخضعها لعمليات التقنية التي يتطلّبها شكل القصة.
كما أنّه من الممكن في ضوء الخبرة الثقافية التي يمتلكها القاص بالنسبة إلى التركيبة البشرية وطرائق استجابتها، أن يرصد أعماق البطل فيصفها أو يصوغها من خلال الحوار الداخلي، أو الحوار الجمعي، شريطة ألاَّ يتجاوز المبادئ العامة التي تحكم استجابات الأشخاص عادة، وإلاَّ فإنَّ الأمانة القصصية تُفرض عليه، بخاصة في عمليات الصراع والشدة والمواقف المعقَّدة، حيث لا يمكن التعرُّف على العمليات النفسية والذهنية التي رافقت الأبطال إلاَّ إذا وقف بنفسه على الحديث المباشر لهم.
الوسيلة الأخرى التي يمكن من خلالها للقاص أن يكون أميناً في نقل الحقائق الذهنية والنفسية للأبطال، هي: قصة (الحوار الداخلي) وقصة (السيرة الذاتية)، فهذان الشكلان القصصيان يتيحان للقاص أن يكون هو البطل ذاته. فالشكل الأول يعتمد تداعيات البطل من حيث تحرّك أفكاره من موقف لأخر، والمحاورة مع نفسه. والشكل الآخر يعتمد النقل المباشر لِمَا خبره القاص من الأحداث والمواقف والبيئات التي تخص تجربته. فإذا افترضنا أنّ القاص الإسلامي كان في صدد صياغة عمل قصصي يتّصل بإمكانيات (التعديل) للسلوك ونقل الآخرين من الظلمات إلى النور، سواء أكان ذلك في نطاق الموقف الفلسفي من الكون، أو النطاق السياسي، أو النطاق
الأخلاقي أو غيرهما، حينئذ بمقدوره أن يتوكَّأ على تجاربه الشخصية (إذا كانت شخصيته قد شهدت فعلاً معالم هذا التعديل).
وأمَّا إذا كان القاص ذا شخصية (منبسطة) حسب المصطلح القصصي، لم يتعرَّض لأزمات فكرية ونفسية، حينئذ بمقدوره - مادام يستهدف تعديل سلوك الآخرين - أن يختار شخصية أخرى تنطبق عليها سمة الشخصية (النامية)، أي الشخصية التي خبرت (تغييراً) في معالم سلوكها (كما لو كانت ضالة فاهتدت). مثل هذه الشخصية - إذا كان القاص ممَّن يرتبط بعلاقة فردية أو علاقة غير مباشرة - بمقدوره أن يرسمها (بطلاً) لقصته بعد أن يكون قد عقد لقاءات مباشرة معها بالنحو الذي أشرنا إليه.
إذاً ثَمَّة أشكال قصصية يمكن أن ينتجها القاص، بنحو يستطيع من خلاله أن يسجّل (الهدف الفكري) الذي ينشده من وراء كتابة القصة، دون أن يقع في مفارقات (الاختلاق) القصصي، ويلغي - من ثمَّ - تلك الاتفاقية الصامتة بينه وبين القارئ في أسسها المختلقة، ويعوضّها بتقديم قصص (واقعية - قد حدثت فعلاً) في هذا الصدد.
الشخصية في العمل القصصي:
الشخصية أو (البطل) في العمل القصصي (روائياً ومسرحياً) يحتلّ كلّ شيء من العمل المذكور، طالما نعرف أنَّ جميع عناصر (القص): الحادثة، الموقف، البيئة، إنّما يحدّدها (شخص) يصدر عنه هذا الموقف أو ذاك، وهذه الحادثة أو تلك، ويتحرك ضمن هذه البيئة أو تلك.
ونحن لا تعنينا طرائق رسم البطل في القصة مادام نمط الرسم في العمل الفني - أيَّاً كان العمل: قصةً، أم شعراً، أم شكلاً آخر - خاضعاً لِمَا يفرضه السياق الفكري الذي يستهدفه الكاتب، إنَّما يعنينا من رسم البطل ما يتوافق مع التصور الإسلامي للشخصية.
الشخصية قد تكون (منحرفة) وقد تكون (سويّة)، والانحراف بنمطيه: الفسق والكفر، من الممكن أن يُرسم في القصة كما هو شأن القصص القرآني الذي يعرض لهذه الأنماط في ضوء التنبيه على كونها ملغاة من الحساب، أو كونها (تعدّل) من سلوكها في نهاية المطاف. وأمّا الشخصية (السويّة - المؤمنة) فتظل هي النموذج بطبيعة الحال.
إنّ ما ينبغي تأكيده في مجال الرسم للبطل هو: الوقوف أمام التيار الأرضي الذي يعنى بظاهرة (الصراع) في رسمه للأبطال.
الصراع بكل أشكاله: صراع البطل مع نفسه، مع الآخرين، مع القوى الكونية المحيطة به، يظل في الأعمال الأرضية تجسيداً لقمَّة الانتكاس البشري المنعزل عن السماء ومبادئها. لقد بدأ الصراع فنياً مع الفكر الوثني للأغارقة، حيث كان العمل المسرحي يأخذ خطورته عصرئذ، وكان الصراع مع أوثانه (الآلهة الخرافية) يشكل لبنة قوية في أساس الفن الغريقي، ثمَّ نما في الفكر الأوربي
الحديث حتى بلغ ذروته في مجالات الجنس والاقتصاد والظاهرة الكونية ذاتها.
إنّ رسم البطل (متصارعاً) مع نفسه، أو الآخرين، أو الوجود، لا يتوافق إسلامياً مع الهدف العبادي الذي يعني: رسم البطل ملتزماً بمبادئ الله، خالياً من التشكيك والتنازع والتوتّر إلاّ في نطاق خاص يتجاوزه البطل في نهاية المطاف.
ويمكننا أن نفيد - كما أشرنا - من القصة القرآنية طرائقَ انتخاب البطل القصصي وفق ما يلي:
١ - انتخاب الأبطال الإيجابيين: كما هو شأن (الأنبياء) الذين رسمهم القرآن الكريم.
٢ - انتخابهم سلبيين: كما هو شأن الأفراد أو المجتمعات التي اكتسحها الطوفان، والريح، والصيحة... إلخ.
٣ - انتخابهم متأرجحين بين الإيجاب والسلب، مع تحديد عدة أشكال لمصائرهم: التحوّل إلى النمط الأخير من الأبطال، بالرغم من كونه يجسّد غالبية مجتمعاتنا، إلاّ أنّ رسمه وفق النموذج القرآني يفضي بالقاص إلى تحقيق مهمته الإسلامية. كما أنّ انتخاب النمط الإيجابي الصرف، بالرغم من ندرته، يفضي إلى الحقيقة ذاتها.
والأمر نفسه بالنسبة لانتخاب البطل السلبي الصرف، مادام المصير المرسوم له يفضي بالمتلقّي إلى أخذ العظة منه، ومن ثمَّ تعديل سلوكه في نهاية المطاف. بَيْد أنّ النمط الثالث (أي: المتأرجح بين الإيجاب والسلب) يظل ميداناً ينبغي للقاص الإسلامي أن يتحرّك من خلاله بحذر كبير، حتى ينجح في تحقيق مهمته الفنية.
ولعل أوضح نماذجه التي ينبغي أن نفيد منها، يتمثَّل في شخوص (السَّحَرَة) الذين رسمهم القرآن الكريم عِبر موقفهم من موسى وفرعون: حيث رسمهم (وقد تحوّلوا إلى الإيجاب) بعد أن عانوا صراعاً تشرحه النصوص المفسِّرة لنا بأنَّه صراع متعدد الأطراف، سواء أكان ذلك ناجماً من نوع المواجهة التي سيرتِّبونها إزاء فرعون، أو كان ناجماً من نوع الاستجابة التي انتهوا إليها.
بَيْد أنّ المتلقّي - وهو يواجه مثل هذا (التحوّل) من السلب إلى الإيجاب - سوف يستثمر ذلك من خلال معطيات متنوعة: فهو أولاً يتعلّم إمكانية التعديل للسلوك ؛ بصفة أنّ الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يمتلك مرونة وطواعية في إمكانات التغيير: حيث تحولّ السحرة من موقف يمثّل الالتواء كلّه، إلى موقف يمثِّل الاستواء كله. ويتعلّم أيضاً شجاعة الموقف وبسالة المواجهة والتحدي لمتسلّطٍ عاتٍ مثل فرعون، حيث هتفوا بوجهه( فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ) . ويتعلّم ثالثاً تفاهة الحياة الدنيا قبال العطاء الأُخروي الضخم من خلال هتافهم المذكور.
وهذا النموذج يجسد النمط الأول من الصراع (التحوُّل إلى الإيجاب).
وأمَّا التحوُّل إلى السلب، فتمثّله شخصية (إبليس) فيما لا تعقيب لنا عليها، مادام التحوّل المذكور يفضي بالمتلقّي إلى تعلم السلوك المضاد له.
وأمَّا النموذج الثالث (استمرارية التأرجح بين الإيجاب والسلب)، فتمثِّله
شخصية صاحب (الجنَّتين) الذي تباهى مدِّلاً على زميله بما لديه من جنّة ومجد، ثمَّ تشكيكه في قيام الساعة، ثمَّ عودته إلى إمكانية التفكير بها( وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ... ) ، ثمَّ الندم على ذلك( لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً ) ... حيث يفيد القارئ منها في تعديل سلوكه عِبر مواجهة هذا النمط من التمزُّق والتوتر والانسحاق، واستمراريتها في الشخص المذكور.
أخيراً يتعيَّن على القاص الإسلامي إلاَّ يعنى بقضايا (الصراع) إلاَّ من خلال مفهومه الإسلامي، المتمثِّل في مواجهته لوساوس الشيطان ودحرها في نهاية المطاف، ومن خلال تحسُّسه بخطورة الذنوب التي ألمَّ بها مثلاً، مقابل تحسُّسه - من الآن ذاته - بإمكانية تجاوز الله تعالى عنها: حيث يظل التأرجح بين الخوف والأمل (بما يواكبه من توتر) مطبوعاً بسمة الإيجاب، على الضد من التأرجح بين الخير والشر في نماذجه الأرضية التي أشرنا إليها، حيث إنّ التأرجح الأول يُحسِّس الشخصية بواقعها العبادي، في حين يظل التأرجح الآخر بمنأى عن إدراك الشخصية المنحرفة لوظيفتها العبادية التي أوكلتها السماء إلى الإنسان، بالنحو الذي تقدَّم الحديث عنه.
الخطبة، الخاطرة، المقالة
ثَمَّة أشكال فنية أخرى لها تميُّزها الشَّكلي عن الشعر والقصة والمسرحية:
منها: الخطبة
وهي شكل فنّي يعتمد الأساس العاطفي في التعبير، مصحوبا بالأدوات الفنية من إيقاع وصورة ونحوهما من العناصر التي تطبع الفن، كل ما في الأمر أنَّ العنصر (العاطفي) - كما قلنا - يظل هو المسيطر عليها بما يواكبها من اللغة المباشرة أيضا.
وتتمثل أهميتها في إحداث التأثير المباشر على الجمهور حيث يستثمر الخطيب: (العقل الجمعي) لدى الجمهور في إحداث الإثارة المشار إليها.
ونظرا لاننا فصلنا الحديث عنها وعن خصائصها الفنية، في الحقل الخاص ب- (الفن التشريعي)، حينئذ نحيل القارئ إلى الحقل المذكور في نهاية الدراسة.
ومنها: الخاطرة
وهي شكل فنّي يعتمد (الإحساس المفرد) أساسا له في التعبير، مصوغة بعبارات قصيرة، مصورة، جميلة: تتناول حركة الإنسان والمجتمع والبيئة في شرائحها اليومية بنحو خاطف وعابر.
أيضا نحيل القارئ إلى حديثنا المفصّل عنها في الحقل الخاص بالفن التشريعي.
ومنها: المقالة
شكل فني يتناول موضوعا محددا من خلال لغة موشحّة بأدوات جالية عابرة دون أن يثقل بها حتى لا يتحول إلى عمل إنشائي، كما لا يتجرّد عن الأدوات المذكورة حتى لا يتحول إلى تعبير علمي.
هذا إلى أنَّنا - كما أشرنا - قد فصّلنا الحديث عن هذا الشكل وسواه في الحقل المتصل بالفن التشريعي، إلاَّ أنَّنا آثرنا الإشارة هنا إلى هذه الأشكال ما دامت بالأجناس الأدبية التي حرصنا على تسجيلها في هذا الحقل، بغية الوقوف عليها واستثمارها في الفن الإسلامي.
النحت والرسم
تعدّ ممارسة (النحت) و(الرسم) في الأعمال الأرضية أمراً مألوفاً في حقل الفن، إلاَّ أنَّ ذلك - من حيث التصور الإسلامي - يظل عملاً غير مسموح به فيما يخص التصوير للإنسان والحيوان فحسب.
أمَّا ما يتَّصل بسواهما، فأمر لا غبار عليه إسلامياً، بل يقترن ذلك بعملية (تثمين) على نحو ما يحدِّثنا القرآن الكريم عن سليمانعليهالسلام ، حيث سخّرت السماء له من قوى الجنّ مَن يعمل المحاريب والتماثيل... إلخ، فيما وردت النصوص عن أهل البيتعليهمالسلام من أنّها تماثيل الشجر ونحوه وليس تماثيل الإنسان والحيوان.
ويثور السؤال: هل بمقدورنا أن نستكنه السر وراء الحظر لصنع التماثيل المتصلة بالإنسان والحيوان دون غيرهما ؟
عبادياً ليس من مهمَّتنا أن نبحث عن السرّ ؛ ما دمنا نعرف تماماً بأنّ (الأحكام) وغيرها (توقيفية)، لا مجال لمسرح العقول القاصرة فيها، فهناك مئآت من الظواهر المسموح بها أو غير المسموح بها نواجهها خلال قصورنا العقلي، الذي يندّ عن إدراك السمة الايجابية لِمَا هو مأمور به، والسمة السلبية للممارسة المنهي عنها.
وإذا كان البعض فيها قد أوضحته الشريعة ذاتها، والبغض الآخر قد أدركته البشرية خلال نموها العقلي في مراحله المختلفة، فإنّ البعض الثالث منها لا يزال مجهولاً بحكم القصور العقلي حيال استكناه الظواهر. ولعل الكشوفات العلمية لاحقاً تتكفَّل بهذه المهمة في هذا المجال أو ذلك.
المهم، أنَّ استشفاف السرّ إذا كان في بعض حالاته متعذراً، فإنَّه في حالات أخرى، ولو في نطاق ضئيل، من الممكن أن يتوفّر عليه الباحث هنا أو هناك، بقدر ما تسمح به خبراته العلمية والفنية في هذا الصدد.
وفيما يتصل بظاهرة (النحت): إذا كان من المسموح للمعنيّ بشئون الفن أن يضع خبراته في استشفاف بعض الدلالات الكامنة وراء الحظر الإسلامي للفن المذكور، فحينئذ لا مناص من الإشارة في البدء إلى أنّ هناك تفاوتاً في لغة (المنع): من حيث الفارق أولا بين المنع المتصل
بتصوير الإنسان والحيوان وبين غيرهما. ثمَّ بين عملية الصنع للتماثيل وبين مجرد اقتنائها، وإنْ كان الاقتناء نفسه محكوماً بدرجة أقل من الحظر في تصوّر آخر للظاهرة. ثمَّ إمكانية وجود فارق بين (النحت) وبين (الرسم) مثلاً. وإمكانية الفارق - من جانب رابع - بين مجرد (الرسم) وبين (حياكته) - مثلاً - إذا كانت الصورة قماشاً، أو بين (تجسيمها) من خلال (التطريز) على سبيل المثال كما يتّضح ذلك من خلال النصوص التشريعية الواردة في هذا الحقل.
إنَّ أمثلة هذه الفوارق قد تُلقي بعض الإنارة على محاولة استشفاف الدلالة النفسية، للغة (المنع) أو (التحفُّظ) حيال هذا الشكل الفنّي أو ذاك.
فيما يتصل بالفارق الرئيس، بين تصوير ذوى الأرواح (الإنسان والحيوان) وبين سواها ؛ من الممكن - كما يعلِّل البعض - أن يكون تجسيم ذي الروح مقترناً بظاهرة (الأصنام) وما تواكبها من الممارسات المتصلة بها، فيتجه الحظر إلى ذلك.
ومن الممكن - كما يرى البعض الأخر - أن تكون عملية (التجسيم) إشعاراً بمشاركة الفنان لله تعالى في الإبداع.
أمَّا التعليل الأول، فلا يمكن الاطمئنان إليه إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنّ التجسيم للشمس مثلاً (وقد وردت الإباحة لها) قد يقترن أيضاً بالتصور (الوثني) لعُبَّاد الشمس، فلماذا لم يتجه المنع إليه ؟ قد يجاب على ذلك بأنَّ (البيئة العربية، التي وردت النصوص في سياقها، لم تألف غير الأصنام )، إلاَّ أنّ ذلك من الممكن أن يُستبعد أيضاً إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنّ الممارسة الوثنية قد اختفت في عصور الأئمة المعصومينعليهمالسلام فيما وردت نصوص الحظر عنهمعليهالسلام .
أمَّا التصوّر الآخر، ونعني به أنّ التجسيم يحسّس الشخص بمشاركته لله تعالى في الإبداع - فأمر له مسوِّغاته في تصورنا، بخاصة أنّ بعض النصوص المعلِّلة للمنع تحوم على هذه الدلالة، من نحو النص القائل: ( مَن صوّر صورة كلفّه الله تعالى أن ينفخ فيها )، ونحو: ( مَن صوّر صورة من الحيوان يعذّب حتى ينفخ فيها )، ونحو: ( مَن صوّر صورة: عُذِّب وكُلِّف أن ينفخ فيها ).
إنَّ أمثلة هذه النصوص التي تحوم على المطالبة بنفخ الروح ؛ تقتادنا إلى استشفاف أنّ الفنان قد يغمره إحساس خاص حيال عمله الفني، كأنّ يتحسّس بكونه قادراً - مثلاً - بتحريك الكائن المنحوت وفق مشيئته.
طبيعياً أنَّ تجسيم الشمس أو الشجر (كما وردت النصوص تبيح ممارستها) قد يقترن أيضاً بأحاسيس مماثلة، إلاَّ أنَّها تختلف تماماً عن الأحاسيس المتصلة بتجسيم الإنسان والحيوان، فهذا التجسيم يظل على صلة بسِمَتي (الإرادة) و(الإحساس)، حينما تقترنان بالتصوّر البشري حيال تحريكهما وفق مشيئة هذا الفنان أو ذاك، إذ تولِّدان فيه نمطاً من الخبرات الملتوية وتسقطانه في شائبة التصوير للروح بنحو أو بآخر.
ومما يعزّز هذا الذهاب أيضاً، ملاحظة الفارق (في لسان بعض النصوص) بين صنع التماثيل وبين اقتنائها، فامتلاكك إيَّاها - مثلاً - لا يقترن مباشرة بمشاعر (الصنع) كما هو واضح ؛ ولذلك نجد بعض النصوص لا تمانع من ذلك، بل تطالب بأن يطرح - مثلاً - شيئاً عليها خلال ممارسة الصلاة... وهذا فيما يتصل بعملية (النحت).
أمَّا ما يتصل بعملية (الرسم)، فقد ورد في بعض النصوص ما يشير إلى المطالبة بتكسير رءوس (التماثيل)، وبتلطيخ رءوس (التصاوير)، حيث نستخلص من ذلك: أنّ المقصود ب- (التصاوير) هو (الرسم) بقرينة (التلطيخ)، وأنَّ المقصود من (التماثيل) هو(النحت) بقرينة (التكسير)، وإلى أنَّ (الرسم) - من ثمَّ - محكوم بنفس المنع. علما بأنَّ عملية التجسيم لِما هو (مرسوم)، من خلال تكثيف عملية الرسم مثلاً، أو تطريزه إذا كان قماشاً، يظل طابعاً مشتركاً مع عملية (النحت) من حيث خضوع كليهما إلى عملية (تجسيم).
وأيَّاً كان الأمر، فإنَّ الممارسات المذكورة، نحتاً كانت أم رسماً، صنعاً كانت أم اقتناءً، من الأفضل عبادياً اجتنابها جمعياً، المحرمة منها إلزاماً، والمتحفّظ حيالها تنزّها، بخاصة إذا أدركنا أنَّ بعض الحروب الإسلامية التي خاضهاعليهالسلام قد اقترنت بتحطيم التماثيل والرسوم التي واجهها في عملية الفتح.
الفنّ واتجاهاته:
تاريخياً نشأت اتجاهات أو مذاهب فنية جاء بعضها صدىً لانعكاسات الفلسفات الأرضية عليها، وبعضها فرضته أوضاع اجتماعية خاصة، وبعضها يمثِّل مجرّد تطوُّر فني أفرزته طبيعة الثقافة العامة لهذا المجتمع أو ذاك.
أمَّا إسلامياً، فلا نعتقد بأهمية مثل هذه الاتجاهات أو المذاهب التي يؤرِّخ لها الأرضيون المعنيُّون بشئون الفن ؛ مادمنا - من جانب - نمتلك تصوراً خاصاً حيال الحياة، ومادامت هذه الاتجاهات - من جانب آخر - لا تجد لها في خارطة الفن المعاصر موقعاً ذا بال، بقدر ما تُمثِّل مرحلة تاريخية تجاوزها المعاصرون، إلاَّ في نطاق محدود لا مانع من العرض لها الآن عابراً حتى نتبيَّن مدى إمكانية التعامل مع دلالاتها ( فنيِّاً )، أو عدم إمكانية ذلك، في ضوء التصور الإسلامي لها.
من هذه المذاهب:
الاتجاه التقليدي:
يتميَّز هذا الإتجاه بطابعه التأريخي من حيث كونه يمثّل مرحلة زمنية تماثلت من خلالها آداب العالم في الخطوط التي طبعتها، فهناك حضارات أُولى أفرزت نمطاً من الآداب يسمها البُعد المنطقي، أي غلبة العنصر (العقلي)، وفخامة اللغة التي فرضها البعد المنطقي المذكور.
ونظراً لانطفاء هذه الحضارات أو توقّف نموها، ثم عودتها مع ما يسمّى بعصور النهضة الحديثة، حينئذٍ فإن إحياءها من جديد فرض فاعليّته على المراحل الأولى من العصر المذكور. ولذلك أصبح هذا التيّار فيما بعد (رمزاً) لمنطلق الآداب القديمة، وأصبح (تراثاً) أكثر منه مذهباً فنياً، بالرغم من أن بعض مبادئه الفنية لازالت محتفظة بفاعليتها من الآداب المعاصرة مثل (عضوية العمل الفني)، أي تلاحم أجزائه الموضوعية بعضاً مع الآخر وارتباطها وفق سببية محكمة، ومثل نظرية ( التطهير - في التراث الأغريقي)، التي تعني إثارة عاطفية (الشفقة) و (الخوف) لدى المتلقِّي، بصفة أن (الخوف) من العقاب يحمل الفرد على تجنّب الخطأ و(الاشفاق) من المصير السلبي للشخص، يحمل الآخرين على التجنّب المذكور.
إسلامياً: تظل عملية ( وحدة العمل الفني ) و( التطهير ) أمراً لا غبار عليه، على أنّ يفصل ذلك من السياق الأرضي له. مع ملاحظة أن القصة القرآنية الكريمة، أو السورة من حيث هيكلها العماري العام، تفرز خطوطاً في ميدان ( وحدة النص ) والإثارة العاطفية ما يغنينا عن ذلك، بخاصة إذا أخذنا الاعتبار أن وحدة العمل الفني في تجارب الأرض، بدأت منحصرة في انتقاء ( موضوع ) محدَّد ترتبط مفرداته بقانون السببية، ثمَّ تطوّرت بعد ذلك إلى تعدّد ( الموضوعات )، مع ارتباطها بوحدة ( فكرية ) تجمع بينها، ثمَّ تطورت - ثالثاً - حتى شملت التلاحم بين مختلف العناصر ( موضوعيَّاً وفنّياً )، أي تلاحم الموضوع مع أدوات الفن من لغة وصورة وصوت... إلخ. وكل أولئك يمكننا ملاحظته في النص القرآني الكريم - سورة أم قصة - بنحو يتجاوز مراحل التطور الأرضي المشار إليه، ممّا يقصر عنه التصور الفني المحدود بطبيعة الحال.
ومنها:
الاتجاه الرومانسي
يقول مؤرّخو الفن بأن هذا الاتجاه يمثّل استجابة عاطفية لمنطقية الاتجاه السابق، حيث برز في القرن الماضي، وهو قرن شهد تغييراً في أوضاعه العلمية والاجتماعية سحب آثاره على الفنانين، ولابد أن يتم ذلك على نحو ( انفعالي ) يتناسب مع عمليات التغيير.
وقد صحب هذا الاتجاه أكثر من مبدأ فني، حيث طوّر مفهوم عضوية العمل الأدبي وجعله متسعاً، تتعدد الموضوعات [فيه] بدلاً من قصرها على واحد، مع ربطها بخيط فكرى يوحّد بينها. كما أنه جنح إلى بساطة اللغة بدلاً من الفخامة التي طبعت الاتجاه الأسبق.
إسلامياً: لا غبار على هذا الجانب الفني من الاتجاه المذكور، مادمنا قد أشرنا إلى أنّ وحدة العمل الفني، بجميع مستوياتها، قد أغنانا القرآن الكريم عن استثمار معطياتها. كما أن بساطة اللغة تظل واحداً من أهم المبادئ الفنية التي يشدّد الإسلام عليها، عبر مطالبته ب- ( الوضوح ) في التعبير.
إلاّ أنّ ( البعد العاطفي ) لدى هذا الاتجاه يظل على الضدّ تماماً من التصوّر الإسلامي، حيث سبق أن أوضحنا بأن الإسلام ينظّم استجابة الشخص وفق طابع سوّى، موسوم بالنضج وبالرصانة وبالتعامل الواقعي مع الظواهر، في حين يظل الاتجاه الرومانسي موسوماً ليس ببعده الانفعالي فحسب، بل يتضخّم درجة هذا الانفعال بنحو فَصَلَ بعض ممارسيه عن أرض ( الواقع ) تماماً، وجنح به إلى عوالم الوهم والتخيّل اللذين يثيران الإشفاق ، فضلاً عن سمة ( الابتذال ) التي طبعت هذا الاتجاه ( عقلياً ) مثل ما طبعته في لغته الفنية أيضاً.
المهم أنّ هذا الاتجاه لا فاعلية له في الحياة الأدبية المعاصرة، إلاّ أنّ طابعه ( الذاتي ) يظل محتفظاً ببعض خطوطه، مع تلوّنها بطابع هذا العصر بكل تعقيداته التي لا فائدة من التحدّث عنها الآن. كما أنّ خطوطه الفنية ( وحدة العمل الأدبي وبساطة لغته )، تظل ذات فاعلية موسومة
بالمستوى ذاته من النسبية التي أشرنا إليها.
ومنها:
الاتجاه الرمزي
هذا الاتجاه نشأ بدوره في القرن الماضي، منطلقاً من الحقائق النفسية التي تذهب - كما يقول مؤرّخو هذا الاتجاه - إلى أنّ استجاباتنا، أو وعينا للشيء، هو الذي يخلع على الظواهر هذه الدلالة أو تلك، وإلى أنَّ ( اللغة ) بصفتها محدودة - من حيث مفرداتها - ترتطم بالحقائق النفسية التي لا حدود لها ؛ مما يستتلي ذلك اللجوء إلى ( الرمز )، بصفته تعبيراً مكثَّفاً ومليئاً بالإيحاءات المتنوّعة التي تشي بمختلف الدلالات: حسب خبرات الكاتب أو القارئ. وهذا يعني أنّ ( الرمز ) تعبير محدود عن معانٍ لا محدودة.
ويضيف مؤرّخو هذا الاتجاه إلى أن حواس الشخصية ( سمع، بصر، ذوق... ) تتبادل التأثيرات فيما بينها ؛ نظراً للغة النفسية التي توحّد بينها، مما يعني أنّها تثرى الإمكانات الإيحائية للرمز.
إسلامياً: لا غبار على هذا النمط من استخدام اللغة، شريطة أن تظل ( الرموز ) محتفظة بوسيلتها، أي بكونها مجرد ( وسيلة ) للإفصاح عن كثافة الدلالة، لا أن يتحوّل إلى غابة كثيفة، مضببَّة، فيما نلحظ ذلك من نتاج الكثير من أصحاب هذا الاتجاه. إنّ التعبير القرآني الكريم تتخلَّله ( رموز ) متنوّعة - أشرنا إلى جانب منها في الدراسة المتصلة بالفن التشريعي - إلاَّ أنّها تتسم بطابع ( الوضوح )، بحيث يمكن استحضار أطرافها دون إرهاق.
وإذا كانت مبادئ الفنّ - إسلامياً - تتمثّل في الاقتصاد والعمق والوضوح ( كما ألمح أئمة التشريع (عليهالسلام ) إلى ذلك )، فإن ( الرمز ) - في نصوص القرآن والحديث - يجسد المبادئ المذكورة تماماً ؛ بصفة أنَّ ( الرمز ) نفسه عملية ( اقتصاد لُغوي )، كما أنَّ سعة الدلالة التي يعبّر عنها الرمز تمثِّل المبدأ الآخر للفن، وهو ( العمق ). فإذا تمّ انتخاب الرمز بنحو غير مضبَّب، حينئذٍ فإن المبدأ الثالث، وهو ( الوضوح )، يتحقق في ذلك أيضاً.
إذاً من حيث التصور الإسلامي للغة الفن، يظل ( الرمز ) حاملاً مسوِّغاته بالنحو الذي أشرنا إليه. وأمَّا أرضياً، فإن هذا الاتجاه - بصفته تياراً مستقلاً بذاته - لا يحتفظ بحدوده المستقلة في خارطة الأدب المعاصر، لكنه يحتفظ بفاعلية كبيرة، لعلها لا تضارعها أيَّة فاعلية أخرى: من حيث جوهر ( الرمز ) وإمكاناته الإيحائية التي لا حدود لها، وليس من حيث كونه اتجاهاً له خطوطه التي تميّزه - تاريخياً - عن غيره من الاتجاهات.
ومنها:
الاتجاه السريالي
وهو اتجاه أفاد من مكتشفات علم النفس التحليلي الذي ظهر مع بدايات هذا القرن، و
تأكيده على فاعلية الحياة ( اللاشعورية ).
ويقول مؤرِّخو هذا الاتجاه، بأن الفنانين قد استثمروا - فنياً وفكرياً - ظهور هذه المدرسة، بعد أن كانت الحرب العالمية الأولى قد تركت في نفوسهم استجابات مريرة، تتمثّل في خيبة أملهم بالحضارة التي أفرزت مثل هذه الحروب.
وبدلاً من أن يتَّجه الفنَّانون - كما هو شأن الشخصية السوية - إلى رفض القيم المادية التي أفرزت أمثلة ذلك الدمار، بدلاً من ذلك اتجهوا - كما يقول المؤرّخون - إلى سلوك مرضي، هو التمرّد على بقايا الحياة الخُلقية التي احتفظ بها المنعزلون عن مبادئ السماء، فجنحوا إلى الفوضى والتهكُّم والسخرية في ضوء وقوفهم على فوضوية الحياة اللاشعورية ومشروعية رغباتها، وإنْ كانت ممنوعة اجتماعياً.. حسب زعم رائد هذه المدرسة النفسية.
إنَّ ما يعنينا - إسلامياً - من هذا الاتجاه، هو انعكاس المكتشفات اللاشعورية على الصياغة الفنية لروّاده، وهو انعكاس لا ينحصر في هذا الاتجاه، بل يتجاوزه إلى مطلق الفنانين الذين أفادوا من مكتشفات اللاشعور في العمل الفني، حيث ركنوا إلى ظواهر مثل ( الحُلْم ) و( التداعي الذهني ) ونحوهما من الأدوات الفنيّة.
طبيعياً، لا غبار على استخدام أمثلة هذه الأدوات ( الحلم، التداعي الذهني،... ) في العمل الفني، مادامت مجرد أداة فنية، بخاصة أنَّ المشرع الإسلامي نفسه قد أشار إلى الحياة اللاشعورية للإنسان، عبر نصوص وردت عن الإمام عليعليهالسلام والإمام السجادعليهالسلام والإمام الصادقعليهالسلام تتصل بظواهر هفوات اللسان، والمزاح، والتكبر، من حيث صلتها باللاشعور الذي اكتشفه الأرضيون في زمن متأخر.
أمَّا فكرياً، فبالرغم من أنَّ الإسلام أقرّ بفاعلية الحياة اللاشعورية، إلاَّ أنَّه يرفض طبيعة التفسير الأرضي، بخاصة التفسير الجنسي والعدواني الذي تقوم عليه أُسس هذه المدرسة. مع ملاحظة أنَّ تلامذة هذا التيار نفسه، قد شكّكوا بقيمة التفسير المشار إليه، كما أنّ الاتجاه المعاصر لمدرسة التحليل النفسي يرفض بدوره أمثلة هذا التأكيد على ظاهرتي ( الجنس والعدوان )، بل إنّ الاتجاه التحليلي الأحداث بدأ يشدّد على ( الأنا ) أو ( الشعور ) بدلاً من المبالغة في فاعلية اللاشعور، وهو أمر يفسِّر لنا مدى تهافت هذه النظرية وإفلاسها علمياً حتى في نطاق البحث الأرضي لها.
***
اتجاهات فكرية
التيارات التي أشرنا إليها ( الكلاسيكية، الرومانسية، الرمزية، السريالية )، بالرغم من كونها منشطرة إلى ما هو ( فني ) صرف، وإلى ما هو مزيج بين الفن والفلسفة الفكرية التي ترفده، تظل متميزة عن اتجاهات أخرى يغلب عليها الطابع الفكري، وهي اتجاهات بدأت مع القرن الماضي، مثل:
( الواقعية ) ( الطبيعية )، ومع القرن الحالي في عقوده الأولى: ( الواقعية الانتقادية ) ( الواقعية الاشتراكية )، وخلال وبعد الحرب العالمية الأخيرة ( الوجودية ) ( اللامعقول )... إلخ.
إنَّ أمثلة هذه الاتجاهات بالرغم من توسّلها بأدوات فنية تفرز اتجاهاً عن آخر، وبالرغم من تباينها فكرياً وزمنيّاً، إلاَّ أنَّها تظل إفرازاً مريضاً من إفرازات الحضارة المنعزلة عن السماء: شرقاً وغرباً، فيما يضادها الإسلام تماماً، وهو أمر يقتادنا ليس إلى رفضها فحسب، بل إلى ضرورة التوفّر على صياغة اتجاه إسلامي محدَّد، يُعنى بالجانب الفنّي في ضوء المبادئ التي نحاول - في هذه الدراسة - الوقوف عندها من خلال مبادئ ( الفن التشريعي ) نفسه - كما كرَّرنا، ومن خلال الخطوط العامة لرسالة الإسلام.
* * *
الحقول المتقدّمة التي عرضنا فيها مجمل التصور الإسلامي للفن، تظل متصلة بظاهرة ( الفن ) من حيث كونه عملاً إبداعياً، وهو أمر يظل متميِّزاً عن عمل آخر، هو دراسة هذا الفنّ من حيث ( تقويمه ) وتبيين قيمه الجمالية والفكرية، وملاحظة مستوياته إيجاباً أو سلباً، حيث ينتظم ذلك حقل خاص هو:
الفنّ ودراسته
عندما نطلق كلمة: ( الفن )، فإنَّها تعني حيناً ما يصطلح عليه باسم ( الفن الإنشائي )، وحيناً آخر ( الفن الوصفي أو المعياري ).
أمَّا الفن أو الأدب الإنشائي، فيقصد به: التجربة الوجدانية التي يصوغها الشاعر أو القاص أو الخطيب، وفق أحد الأشكال التي تقدم الحديث عنها ( القصيدة، القصة، المسرحية، الخاطرة، الخطبة... إلخ ).
وأمَّا الفن أو ( الأدب الوصفي )، فيقصد به: دراسة الأشكال الفنية المذكورة ( القصيدة، القصة، المسرحية... إلخ )، أي: تبيين القيمة الفنية لها، من حيث كونها جيدة أم رديئة، بما يواكب ذلك من محاولة تحليلها وتفسيرها. وهذا النمط الأخير - أي: الأدب الوصفي - يتميّز عن سابقه ( الأدب الإنشائي )، بكونه يعتمد: التعبير المباشر أو العلمي أو العادي.
لذلك، فإن إطلاق اسم ( الأدب ) أو ( الفنّ ) عليه، يظل تجوّزاً وليس حقيقة ؛ بصفة أنَّه لا يختلف عن البحث العلمي الذي يتناول دراسة إحدى الظواهر وفق منهج خاص، قائم على الملاحظة والاستقراء والاستنتاج.. ونحوها، مما هو مألوف في دراسة العلوم الإنسانية أو البحتة. كل ما في الأمر، أن الدارس الفني من الممكن أنَّ يعتمد، ولو جزئياً، لغة الفن من: ( تخيّل ) و( عاطفة ) و( إيقاع ) ونحوها.. مما ينتظم الأدب الإنشائي، كما أنه من الممكن إلاَّ يعتمد ذلك، فيحصر معالجته في اللغة العلمية البحتة، أو يوشحها عابراً بلغة الفنّ.
المهم، أنّ دراسة الفنّ تظلّ منتسبة بعامة إلى لغة ( العلم ) وليس إلى لغة ( الفن )، وهو ما نحاول تسجيله في هذا الحقل الذي أسميناه ب- ( الفن ودراسته).
* * *
نظرية الفنّ:
ولعل أول ما ينبغي تسجيله في هذا الحقل، هو: تحديد مستويات ( الدراسة للفن )، حيث يمكن دراسته من خلال (النظرية ) فحسب، كما لو قمنا بعملية تعريف للفن، وماهيته، ووظيفته ،
وعناصره، وأشكاله، واتجاهاته... إلخ، وهو ما ينسحب عليه طابع ( الدراسة ) التي قدّمناها في الحقول السابقة.
ويمكن دراسة الفنّ أيضاً ليس من خلال ( النظرية )، التي تعني صياغة القواعد أو المبادئ أو القوانين للفنّ، بل من خلال ( التطبيق )، أي: دراسة النص الإنشائي ( قصة، مسرحية... إلخ ) في ضوء القوانين الفنية المشار إليها، أو دراسة النص الوصفي ( كما لو حاولنا تقويم الدراسة نفسها، مثل تبيين مواطن الجودة أو الرداءة في الدراسة النظرية أو التطبيقية التي يقدّمها الدارس).
بَيْد أن الدراسة ( التطبيقية ) المشار إليها، قد تأخذ طابعاً عاماً ( كما لو درسنا القصيدة من خلال تبيين قيمتها فنياً وفكرياً )، وهو ما يطلق عليه اسم ( النقد الأدبي أو الفنّي ). وقد تأخذ الدراسة طابعاً خاصاً هو: محاولة التأريخ لها، أي: إخضاعها للبعد التاريخي، من حيث نشأة الفن وتطوّره ومراحله... إلخ.
وبالرغم من أن ( النقد الأدبي ) في أحد أشكاله - وهو ( النقد التاريخي ) - من الممكن أنَّ ينهض بهذه المهمة، إلاَّ أن الدارسين اعتادوا أن يفرزوا نمطين من ( التأريخ ):
أحدهما: وضع النص المدروس في إطاره الاجتماعي الذي ولد فيه، وهو ما يخص ( النقد التاريخي ).
والآخر: دراسة الفن من حيث كونه ظاهرة تندرج ضمن التأريخ العام للبشرية، فيؤرَّخ له كما يؤرَّخ للأحداث الاجتماعية أو السياسية أو سواهما، وهو ما يخص ( تاريخ الأدب أو الفنّ ).
وفي ضوء هذا التمييز نتقدّم إلى دراسة ( النقد الأدبي ) أولا، ثمَّ دراسة ( تاريخ الأدب )... حيث نبدأ الآن بدراسة:
النقد الأدبي أو الفنّي
يمكن تعريف ( النقد ) بأنَّّه عملية ( كشف ) للنصوص، أي تبيين قيمها الفنية من حيث الجودة أو الرداءة، وذلك من خلال ( تحليل ) أجزائها و( تفسيرها ) و( الحكم ) عليها.
وهذا يعني أنَّ عملية ( الكشف ) تتضمن ثلاثة عناصر هي:
١ - التحليل : كما لو قمنا بتفكيك القصيدة - مثلاً - إلى أجزاء مختلفة تتصل بعناصرها، من ( فكر ) و( انفعال ) و( صورة ) و( إيقاع ) و( تخيّل )... إلخ، أو تفكيك ( الصورة ) وتحديد أطرافها، أو تفكيك إيقاعها من فرز لعناصر التفعيلة - مثلاً - إلى التجانس الصوتي للعبارة، إلى ( الجرس ) الخاص بها... إلخ. كلّ أولئك يجسّد عنصر ( التحليل ) لمركَّبات القصيدة.
٢ - التفسير : وهو تبيين أو شرح أو إلقاء الإنارة على الأجزاء المحللة المشار إليها، كما لو قمنا بعملية فكّ لرموزها وصورها الغامضة مثلاً.
٣ - الحكم : وهو إلقاء وجهة نظرنا الايجابية أو السلبية على النص، مشفوعة بعنصر ( التعليل ) للحكم المذكور، أي: تقديم الأسباب الفنية الكامنة وراء ( حكمنا ) على النص.
والجدير بالملاحظة أن هناك اتجاهاً يكتفي من عملية ( النقد ) بعنصري ( التحليل ) و( التفسير ) فحسب، دون أن يعنى بعنصر ( الحكم ) ؛ مستنداً في ذلك إلى وجهة النظر الذاهبة إلى أن ( المتلقِّي ) ينبغي أن ( يساهم ) في عملية الكشف للنص، لا أن نحصر الكشف في نشاط الناقد وحده، وذلك لجملة من الاعتبارات:
منها: أن مساهمة المتلقِّي في عملية ( الكشف ) سوف تزيد من إمتاعه لتذوّق النص، وتثرى تجربته في عملية التذوق، بدلاً من أن نقدّم له وصفة جاهزة تحتجزه من ممارسة الإبداع، وهذا يعني أن المتلقِّي يقوم بعملية فنية مكمّلة لمهمة الناقد.
ومنها: أن للمتلقّي وجهة نظره الخاصة في عملية التذوّق، ممّا يتنافى مع ( الحكم ) الذي يطلقه الناقد على النص، وهو أمر يجعل كون النقد منحصراً في عمليتي ( التحليل ) و( التفسير ) دون ( الحكم) له مسوغاته في هذا الميدان، مادامت معايير الفن وقوانينه ( نسبية ) وليست مطلقة.
ومنها: أن الأعمال الفنية ، بخاصة الأعمال الخالدة لكبار الفنانين، لا حاجة لإصدار ( الحكم )
عليها مادامت مستوفية لشرائط الفن.
ومنها: أن عمليتي التحليل والتفسير ذاتهما تكشفان عن ( قيمة ) النص دون الحاجة لإصدار الحكم.
وفي تصورنا، أن الركون إلى ( التقويم ) أو ( التفسير والتحليل )، يظل محكوماً بطبيعة الموقف. فقد يستدعي السياق مجرد عملية ( وصفية ) للنص، وقد يتطلّب الموقف ( أحكاماً ) عليه، إلاّ أن عملية ( الحكم ) بنحو عام تظل هي المهمة الرئيسة للنقد، مادمنا - إسلامياً - مطالبين بنصح الآخرين وإرشادهم، حيث يفيد صاحب النصّ من الملاحظات النقدية على نتاجه، كما يفيد الفنانون الآخرون من الملاحظات المذكورة، فضلاً عما يفيده ( المتلقِّي / القارئ ) من ذلك أيضاً.
* * *
إن عملية ( الكشف ) للنص تقترن بجملة من المبادئ، منها ما يثيره النقّاد حيال عمليات التفسير أو التحليل أو الحكم، من حيث تناولها للنص وشطره إلى ( شكل ) و( مضمون ). فيما يذهب النقاد الجماليون بخاصة ( وهم النقّاد الذين يعنون بالفن من حيث كونه تعبيراً ( جميلاً ) فحسب، بغض النظر عن دلالته ) إلى صعوبة عزل الشكل عن ( دلالة ) النص، حيث يترتب على مثل هذا الاتجاه غياب المضمون الفكري أساساً، وهو ما يتنافى مع العناية الإسلامية بالمضمون كما هو واضح.
الناقد الإسلامي بمقدوره أن يتجاوز هذا المبدأ ( المفتعل )، ويتجه إلى عزل الشكل القصصي أو الشعري - مثلاً - عن مضمونه، دون أن يترتب على ذلك: تضييع ل- ( قيمة ) النص.
صحيح أن الإمتاع الفني لا يتحقَّق إلاّ من خلال وحدة العمل الأدبي - وهو أمر يؤكّده الالتزام الإسلامي كما سبقت الإشارة إلى ذلك - إلاّ أن ذلك لا يحتجز الناقد من فكّ ( الوحدة ) أو ( المركب ) وإرجاعه إلى ( الأجزاء ) التي انتظمت فيه، بل يمكن القول إن الفارق بين العمل الفني وبين دراسته هو: قيام العمل الفني على شكل ( تركيبي )، وقيام الدراسة على شكل ( تحليلي )، أي أن تحليل المركبات هو الوظيفة الرئيسية لعملية النقد.
من هنا فإن إكساب المهمة النقدية نفس المهمة الفنية يظل أمراً مضاداً تماماً لطبيعة العمل النقدي.
يترتب على المبدأ المذكور، مبدأ آخر يتمثّل في ذهاب النقّاد الجماليين إلى ضرورة تناول النص من خلال ( الوحدة ) المشار إليها، دون التناول ( الجزئي ) لها. فإذا افترضنا أن القصيدة - مثلاً - تتركّب من ( تخيّل ) و( عاطفة ) و( إيقاع)، حينئذٍ يظل من الممتنع - في نظر الاتجاه الجمالي في النقد - تناول الجزئيات المذكورة منفصلة عن ( الشكل ) الكلّي لها.
هنا نكرّر نفس الكلام السابق من أن وظيفة الناقد هي تفكيك المركّب وتناول جزئياته منفصلة عنه حيناً، أو وصلها - من جديد - بالمركب المذكور، حسب ما يتطلبه الموقف.
إن بعض المواقف تتطلّب رصد أفكار جزئية من النص، كما لو حاولنا - على سبيل المثال - أن ننتزع من السورة القرآنية (وهي أساساً تقوم على هيكل عماري محكَم ) العنصر القصصي، أو الصوري أو الإيقاعي أو الفكري ( ظاهرة الجهاد، الإنفاق،.. إلخ )، حينئذٍ فإن التناول الجزئي المذكور قد يفرض ضرورته، كما لو استهدفنا الحديث عن ( الجهاد ) أو (الإنفاق) - مثلاً - حيث تفرض المهمة العبادية على الناقد أن يعنى بهذا الجانب السياسي أو الاقتصادي من النص، لكن دون أن يحتجزه ذلك من التناول الفني للظاهرة كما لو وصل بين إحدى الصور الفنية للإنفاق مثلاً( كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ... ) وبين الأهمية العبادية للإنفاق ذاته، ويكون الناقد - بهذا التناول الجزئي - قد حقّق مهمته العبادية من خلال اللغة الفنية التي توفّر عليها، كما هو الأمر في المثال السابق.
وقد يستدعي الموقف إبراز الظاهرة الإعجازية للقرآن الكريم مثلاً، حينئذٍ بمقدوره أن يتحدّث عن السورة كاملة من حيث كونها عمارة محكمة تتلاحم أجزاؤها بعضا مع الآخر.
إذاً: في الحالات جميعاً، تظل تجزئة النص أو وحدته محكومة بمتطلّبات الموقف ( العبادي ) للناقد، دون أن يترتّب على ذلك أي إخلال بمهمته الفنية أيضاً، بالنحو الذي تقدم الحديث عنه.
لغة النقد
والآن، بعد أن ألممنا عابراً بطبيعة النقد وقضاياه، يحسن بنا أن نعرض ل- ( لغة النقد ) من حيث التصور الإسلامي لهذا الجانب.
إن عملية ( النقد ) بنحو عام، وجدت لها نماذج ( شرعية ) لدى المعصومينعليهمالسلام ، فالنبيصلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة ( ع ) طالما ثمّنوا مواقف الشعراء وأغدقوا عليهم الهدايا ؛ تعبيراً عن ( الحكم ) على نتاجهم، أي الحكم بالجودة على ذلك، ممّا يعين أن نقد النص من خلال إظهار محاسنه ( وهو أحد عناصر التقويم الثلاثة: إظهار المحاسن، إظهار المساوئ، الوقوف عند التحليل والتفسير فحسب ) يظل أمراً مشروعاً، بل يمكن القول بأنه يظل أمراً ( مندوباً )، طالما يقتاد التقويم الايجابي إلى تشجيع الفنان لمواصلة المزيد من وظيفته الإسلامية.
كما أن التقويم السلبي ( أي إظهار المعائب ) وجد له نماذج شرعية أيضاً، حيث إن المعصومينعليهمالسلام كانوا يقترحون على الشاعر أن يستبدل بيتا بآخر مثلاً، أو يطالبونه بإلقاء الموضوعات الهادفة فحسب، وعدم قراءة مقدمة القصيدة التي تستهل، وفقا للتقاليد الفنية عصرئذٍ، بالغزل ونحوه.
إن أمثلة هذه الاقتراحات تفصح عن أن ملاحظة النص من حيث جوانبه السلبية، يظل أمراً له مشروعيته أيضاً، بخاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن ملاحظة الجانب السلبي والتنبيه عليه في مطلق السلوك، يظل في الصميم من توصيات المشرّع الإسلامي، الذي يطالبنا جميعاً بنصح الآخرين وتنبيههم على أخطائهم، حيث يدخل ( العمل الفني ) ضمن مفردات ( السلوك ) العام أيضاً.
إذاً، لا غبار على عملية النقد أساساً من حيث الحكم على النص بالجودة أو الرداءة، كلّ ما في الأمر أن لغة النقد - كما أشرنا - ينبغي أن تحكمها الموضوعية من جانب، وأن تتسم بالبعد الأخلاقي من جانب آخر. بمعنى أن التعامل بالحسنى ( في حالة النقد السلبي ) يظل غير منفصل عن السلوك العام الذي يطالبنا المشرّع الإسلامي بالصدور عنه.
ولعل التوصيات الإسلامية المطالبة بمفهومات من نحو: ( العدل ) ( قول الحقّ ) ( الإنصاف )... إلخ، ممّا تشكّل جوهر السلوك السوي، تظل منسحبةً على ( العمل النقدي ) أيضاً. بل يمكننا أن نستخلص هذه الحقيقة بوضوح حينما نقف على توصيات خاصة في هذا الميدان، أو حينما نقف على نماذج تطبيقية للمعصومينعليهمالسلام تكشف عن أهمية ( البعد الموضوعي ) في النقد... من ذلك مثلاً: ما ورد عن النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم من أنه لو ( احتكم ) طفلان مثلاً إلى أحد الأشخاص حيال أفضلهما خطاً أو كتابة، كان من الضروري على الشخص أن يحكم ب- ( العدل ) حيال هذه القضية.
فإذا كان مجرد الخط أو الكتابة لطفلين، وهو عمل عادى، يتطلّب - في التوصيات الإسلامية - ( موضوعية ) في الحكم، حينئذٍ فإن ( الموضوعية - الحياد ) في إصدار الحكم على العمل الفني، تفرض ضرورتها - دون أدنى شك - على الكاتب الإسلامي.
الاستشهاد بالنموذج المعروف الذي أصدره الإمام عليّعليهالسلام حيال أحد شعراء الجاهلية، حينما حكم (ع) بجودة نتاجه ( من حيث الأداة الفنية )، مع أنهعليهالسلام وسم النتاج المذكور، أو وسم صاحبه، بالطابع الانحرافي (الضلال)،... وهو أمر يكشف عن ( الموضوعية ) في أرفع مستوياتها، مما يعني أن الطابع الموضوعي في النقد، يظل في الحالات جميعاً، موضع عناية المشرع الإسلامي.
* * *
هذا كلّه فيما يتصل بالبعد ( الموضوعي ) في النقد.
أما ما يتصل بالبعد ( الأخلاقي ) منه، فإن لغة النقد، وفق التصور الإسلامي لها، ينبغي أن تتسم بنفس لغة التعامل الاجتماعي مع الآخرين، من حيث الالتزام بالآداب العامة من عمليات الإرشاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ حيث لا فارق البتة بين لغة منطوقة ولغة مكتوبة...، بين لغة تتناول السلوك الفردي والاجتماعي ولغة تتناول السلوك الفني.
إن كلاًّ من عمليتي ( التجريح ) و( الفضح ) اللذين نألفهما في النقد الأرضي، ينبغي أن يتنزّه الناقد الإسلامي عنهما.
صحيح أن إبراز المساوئ الفنية في النص تفضي إلى عملية ( فضح ) لصاحب النص، إلا أن هذا الأخير ينبغي أن يتقبّل ذلك برحابة صدر مادام النص الأدبي ملكا للآخرين وليس لكاتبه فحسب، وهو ما يفترق تماماً عن السلوك الشخصي فيما يتعين إرشاد الشخص مباشرة دون فضحه أمام الآخرين... وهذا يعني أن هناك فارقاً بين نقد السلوك الفردي وبين نقد نتاجه الفني، وهو أمر
يتعيّن التشدد عليه في هذا الجانب. كما يترتب عليه جانب آخر يظل في غاية الأهمية بالنسبة للناقد الإسلامي... إننا نعرف - مثلاً - أن هناك اتجاهاً نفسياً في النقد ( حيث سنتحدّث عنه في حقل لاحق ) يحاول ربط النص الأدبي بنفسية كاتبه، حيث يُلاحظ أن روّاد هذا الاتجاه يجنحون في الغالب إلى ( فضح ) كاتب النص وإخضاع شخصيته للتحليل النفسي، وهو تحليل يُعنى بإبراز السمات الشاذة للكاتب.
إن الشاعر أو القاص مثلاً يظل - مثل سائر النماذج البشرية - محكوماً بعقده المختلفة، وإفرازاتها المتمثلة في سمات من نحو: الإحساس بالنقص أو العظمة الموهومة أو المخاوف أو الوساوس، بما يستتبعها من الصدور عن ( آليات ) مختلفة، مثل: الإسقاط، النكوص، التسويغ... إلخ. فإذا اتجه الناقد إلى إبراز هذه السمات، حينئذٍ تظل هذه العملية بمثابة ( تشهير ) و( فضح ) للقاص أو الشاعر، يتنافى أساساً مع ( أخلاقية ) الشخصية المسلمة.
إن الناقد نفسه من الممكن أن تطبعه نفس السمات المرضية التي خلعها على كاتب النص، بل إن ( التشهير ) نفسه يجسد ( نزعة عدوانية ) تفصح عن شذوذ صاحبه،... وحينئذٍ ما فائدة أن يشخّص الناقد ( حالة مرضية ) تطبع شخصه بمثل ما تطبع شخصية كاتب النص... إن أمثلة هذا النقد دفعت الكثير من روّاده إلى الوقوع في أحكام لا تقف عند مجرد التشهير أو الفضح لعيوب خفية، بل تجاوزت ذلك إلى محاولة ( افتعال ) التهم وإلصاقها بكاتب النص، من نحو ما نلحظه من تفسيرات تتحدث عن شعراء وقصَّصين أخضعوا نتاجهم لتقاليد فنية لا علاقة لها بسلوكهم الشخصي، أو لوحظ أنهم - في السلوك الشخصي - قد طبعهم بعض الشذوذ، فالتمسوا لنتاجهم تفسيرات متعسّفة في ضوء وقوفهم على الشذوذ المذكور. فضلاً عن محاولتهم تفسير ما هو إيجابي عند بعض الفنانين - كما لو كانوا إسلاميين أو زهّاداً مثلاً - بأنه عملية ( تعويض ) لفشل، أو ( قناع ) لنزعة عدوانية، أو ( تصعيد ) لرغبة جنسية... إلخ.
أمثلة هذا النقد تظل غير متوافقة أساساً مع الاتجاه الإسلامي الذي لا يصدر ( الحكم ) إلاّ بعد اليقين بوجود الصلة بين نتاج الكاتب وشخصيته، وحتى بعد يقينه بذلك، لا يحقّ له - كما قلنا - فضح الشخصية، بل يجب أن يتستر عليها كما هو صريح التوصيات الإسلامية المطالبة بذلك، وبعدم الجهر بالسوء مادام الأمر غير مرتبط بالجانب الفنّي من النتاج، بل بالجانب الشخصي الصرف.
لكن تستثنى من ذلك - بطبيعة الحال - النماذج المنحرفة التي تجهر بممارسة الرذيلة، أو النماذج المنحرفة التي ( تتقنّع ) بما هو ايجابي من السلوك بغية تمرير نزعتها الشريرة على الآخرين، حيث يتطلّب مثل هذا الموقف عملية فضح وإدانة للنماذج المشار إليها.
النقد واتجاهاته
بعد أن وقفنا على طبيعة النقد الفني ولغته، يحسن بنا أن نقف على تياراته أو اتجاهاته الأرضية، لملاحظة الموقف الإسلامي منها.
لا شك أن الناقد - أيَّاً كان اتجاهه - يتوسّل عبر تقويمه للنصوص بالأداة الرئيسة للفن. فإذا كان في صدد دراسة القصيدة الفنية التي تنتظم هذا الشكل الأدبي أو ذاك، فللقصيدة مثلاً لغتها الخاصة، وعناصرها التخيلية والعاطفية، وللمسرحية: لغتها وشكلها وبناؤها الخاص... وهكذا.
والأصل في الممارسة النقدية أن يعتمد الباحث الأداة الفنية الخاصة بذلك النص الذي يعتزم دراسته، بَيْد أن النص - في الآن ذاته - يرتبط بمقومات اجتماعية أو دلالات نفسية أو دلالات فكرية، مما يفرض على الناقد لقاء الإنارات المذكورة عليه، فيتجه إلى ( خارجه ) أيضاً، وهو أمر يجعل عملية ( النقد ) مقترنة بمبادئ أخرى قد يتفاوت الباحثون حيالها، بخاصة أن ذلك يظل خاضعاً لنسبية هذه الإنارة الخارجية، كما يخضع لوجهة النظر العقائدية للناقد. كلّ أولئك يقتادنا إلى عرض المبادئ ( الخارجة ) عن النص، وملاحظة التيارات أو الاتجاهات النقدية في هذا الصدد، ثم عرض التصور الإسلامي لهذا الجانب.
ونبدأ - أولاً - ب-:
الاتجاه العقائدي:
يقصد ب- ( الاتجاه العقائدي أو الأيدلوجي): دراسة النص في ضوء الموقف الفلسفي الذي يصدر الكاتب عنه. والملاحظ أن الكتّاب - قديماً وحديثاً - أثاروا هذه الظاهرة في حقل الدراسات العلمية، حيث انشطروا حيال ذلك إلى اتجاه رافض لإقحام ( الموقف الفلسفي ) في دراسة النص، واتجاه ملتزم بأهمية مثل هذا الإقحام.
أما إسلامياً، فإننا في غنى عن أثاره هذه الظاهرة ؛ مادمنا مقتنعين تماماً أن الشخصية الإسلامية ( موظّفة ) أساساً في كلّ تصرفاتها، بما في ذلك السلوك العلمي.
الشخصية الإسلامية مدركة تماماً بأن ( السماء ) أبدعتنا لهدف خاص هو ( الخلافة في الأرض )، بمعنى أننا نمارس هذا السلوك أو ذاك، تبعاً لإحساسنا بمسئولية ( الخلافة )، بما في ذلك السلوك الحيوي الذي لا مناص من إشباعه، مثل: الطعام والنوم ونحوهما. وقد وردت التوصيات الإسلامية بضرورة أن تضع الشخصية الإسلامية في اعتبارها ( هدفاً ) عبادياً بالنسبة لكل تصرف يصدر عنها بما في ذلك الأكل والنوم، مطالبة إيانا أن تكون لنا ( نية ) حيالهما، وحيال سائر أنماط سلوكنا.
وإذا كان الأمر كذلك، فإن السلوك العلمي يجيء في مقدمة الوظائف الخلافية التي أوكلتها ( السماء ) إلينا، مما يعني أن ( المنهج العقائدي ) في دراسة النصوص، يظل ( هدفاً أوحد ) بالنسبة للباحث ؛ إذ بدون وضع الهدف المذكور في حسبانها، يظل البحث عقيماً لا جدوى فيه، وهو أمر تطالبنا السماء بالتنزّه عنه.
لذلك، لا نجد أي معنى لطرح التساؤلات عن مشروعية دراسة النص في ضوء ( العقيدة ) أو عدمها، مادام هدفنا أساساً هو ( العقيدة ) ذاتها، من حيث إشاعتها في النفوس ونشرها بين الجمهور.
بَيْد أن الباحث الإسلامي عبر ممارسته لهذه المهمة ( العقائدية )، ينبغي - كما أشرنا سابقاً - ألاَّ يغيب عن ذهنه بأن البحث العلمي لابد أن يتسم بطابع ( الموضوعية ) أو ( الحياء ) من حيث دراسته للظواهر التي يتناولها، ليس بمعنى عدم تصوير ( هدفه العقائدي )، بل بمعنى أن الدراسة ينبغي ألاّ تتأثر ( عاطفياً ) بالموقف الفلسفي، بحيث يخرجها من دائرة المعالجة الموضوعية، بل تتناول النص بروح خالية من آثار العاطفة وانفعالاتها، ملتزمة بالحياد العلمي، مجادلة بالتي هي أحسن.
بكلمة جديدة: الكاتب الإسلامي مدعو إلى أن يدرس الموضوع بشكل ( محايد ) أولاً، ثم يتجه إلى تقويمه ( عقائدياً ). فإذا افترضنا أن الكاتب كان في صدد دراسة قصيدة مثلاً، حينئذٍ يتعيّن عليه أن يعالج القصيدة المذكورة من حيث قيمتها الفنية، بما تنطوي عليه من صياغة الصورة والإيقاع واللغة ونحوها، ثم يتّجه إلى تقويها ( عقائدياً ). فإذا كانت القصيدة - على سبيل المثال - رديئة الصياغة، بالرغم من كونها ( إسلامية ) المنحى، ينبغي ألاّ يتعصّب لها فيحكم بجودتها ( فنياً ) مع أنها رديئة، بل يتعيّن عليه أن يقر بكونها غير جيدة، من الزاوية الفنية.
بالمقابل، ينبغي على الباحث أيضاً إذا كان في صدد دراسة إحدى القصائد ( غير الإسلامية ) مثلاً، ألاَّ يتعصب ضدها من الزاوية الفنية، إذا كانت مستجمعة لشروط ( الفن )، بل يقوّمها بنحو ( موضوعي )، ثم يتجه إلى إسقاط قيمتها ( عقائدياً ). وهذا ما نلحظه لدى أئمة أهل البيت ( ع ) فيما كانوا يصدرون في أحكامهم عن هذا التناول الموضوعي للظواهر، حيث يطالبون الشاعر ( العقائدي ) مثلاً، بإسقاط أو تعديل العبارة أو البيت الشعري ( من الزاوية الفنية )، كما يقرّون الشاعر ( غير العقائدي ) بجودته فنياً، إلاّ أنهم يحكمون بضلالة أفكاره.
إذن، ليس ثَمَّة منافاة البتة بين أن يجمع الباحث بين ( الحياد ) العلمي وبين معالجته للنص ( من الزاوية العقائدية )، بل يتعيّن عليه أن يتوفّر على مثل هذا المنهج الذي يزاوج بين الحياد العلمي والالتزام العقائدي، مادام عدم التحامهما يفضى إما إلى الوقوع في هاوية ( العبث )، في حالة معالجته للنص ( فنياً ) فحسب، دون إقحام البُعد العقائدي فيه، وهذا ما يتنافي أساساً مع وظيفته العبادية الهادفة. وإما أن يقع في تشويه الحقائق وتحريفها، في حالة عدم تقويمه للنص فنياً.
طبيعياً، ينبغي أن يضع الكاتب الإسلامي في حسبانه بأن دراسة النص أو الموضوع غير المتسم بطابع إسلامي يظل عملاً عابثاً، بل محظوراً من الزاوية العبادية، إلاَّ في حالة اعتزامه الرد عليه وتبيين انحرافاته. ولذلك لا يرد على الكاتب الإسلامي ما يورد اعتيادياً على الباحثين غير الإسلاميين أو غير الملتزمين، طالما يتنزه الباحث الإسلامي عن دراسة النصوص المنحرفة فكرياً، ولا يجد ثَمَّة حاجة إلى تناولها إلاّ في حالة الرد عليها، كما أشرنا، نظراً إلى أن ممارساته ( ومنها الممارسة العلمية ) تتسم بكونها ( هادفة ) لا مجال للعبث فيها.
نخلص من ذلك إلى أن ( المنهج الأيدلوجي ) يظل بالنسبة إلى الباحث الإسلامي هدفاً رئيسياً في ممارسته العلمية، أي أن هدفه أساساً هو ( المنهج الأيدلوجي ). وأما سائر المناهج ( الفنية والنفسية والتاريخية )، فتجيء ( موظَّفة ) لإنارة ( عقائده )، أي تجيء ثانوية الأهمية بالقياس إلى أهمية ( المنهج العقائدي ) ؛ لبداهة أن أية ممارسة علمية ينبغي أن ( توظَّف ) من أجل ( العقيدة ).
الاتجاه الجمالي:
يقصد ب- ( الاتجاه الجمالي ) في النقد: دراسة النص في ضوء المبادئ الفنية له، دون تسليط أي ضوء خارجي عليه. بمعنى أن الناقد إذا كان في صدد دراسة القصيدة أو القصة مثلاً، حينئذ فإن دراسته تنحصر في معالجتهما من حيث عناصر النص وأدواته ولغته، مثل: الإيقاع، الصورة، الحوار، السرد... إلخ.
وهذا الاتجاه قد تفرضه سياقات خاصة من التناول، كما لو افترضنا أن ناقداً كان في صدد دراسة البناء الفني للسورة القرآنية، من حيث كونها ذات موضوعات يرتبط أحدها مع الآخر بسببية محكمة، وتتنامى أجزاؤها وفق تماسك عضوي، بحيث تبدأ السورة بموضوع، وتتدرّج إلى آخر، وتنتهي إلى الخاتمة، وفق ترتيب منطقي ( زمني أو نفسي ). بَيْد أن كثيراً من النصوص تتطلب الاستعانة بضروب أخرى من المعرفة ( التاريخية ) أو ( النفسية ) مثلاً، وحينئذٍ فإن التوسّل بالمعرفة المذكورة يظل أمراً لا مناص منه.
ومن الممكن أن يثير بعض المعنيين بشئون الدراسات الفنية تشكيكاً بقيمة الدراسات التي تتجاوز نطاق المنهج الفني إلى ( المعرفة ) الخارجة عنه، مدّعين في ذلك أن إخضاع الدراسة إلى المعرفة الخارجية يحوّلها من نطاق الدراسة الفنية إلى دراسة تاريخية أو نفسية أو علمية بعامة، مما يفقدها السمة الأصلية لها، وهو الفنّ أو الأدب.
لكن، من الممكن أن نجيب أمثلة هؤلاء الباحثين، بأن الفارق بين الأدب والفن وبين دراستهما، لابد أن يؤخذ أولاً بنظر الاعتبار من حيث كونهما - أي الأدب والفن - عملاً إنشائياً أو إبداعياً، ومن حيث كون ( البحث العلمي ) عملاً وصفياً يستهدف تحليل النص وتفسيره وتقويمه، مما يتطلّب معالجته في ضوء المعلومات التاريخية التي ولد النص في نطاقها، وفي ضوء المعلومات النفسية التي تُسعِف القاري - فضلاً عن الباحث - في فهم أسرار العمل الفني أو الأدبي. فنحن لا يمكننا تقويم النص من خلال مجرد تحليل الصورة الفنية - كالتشبيه مثلاً - ما لم نُخضِع الدراسة للمعرفة النفسية التي تُلقي الضوء على أسرار ( التشبيه ) الجيد وفرزه عن التشبيه الرديء.
إن عملية ( الإبداع الفني ) ذاتها، تعد في الصميم من مهمات العالم النفسي، كما أن عملية ( التوصيل الفني ) تعد في الصميم أيضاً من وظائف العالم المذكور، من حيث دراسة ( الاستجابة )
البشرية وطرائقها في هذا الصدد.
والأمر ذاته يمكننا أن نلحظه في سائر الموضوعات أو النصوص التي نتناولها بالدراسة... سواء أكانت أدباً أم تاريخاً أم اجتماعاً أم اقتصاداً أم تشريعاً أم سياسة... إلخ... طالما نعرف بأن ( العلوم ) ( إنسانية ) كانت أم ( بحتة )، تتداخل فيما بينها بشكل أو بآخر، مما تستلي بالضرورة تسليط أحدها على الآخر، ولكن وفق ( نسبية ) محدّدة وليس بالنحو المطلق.
فضلاً عن ذلك، فإن كلاًّ من المعرفة ( التاريخية والنفسية ) تكاد تنفرد عن سواها من ضروب المعرفة الأخرى، بكونها تشكل ( أداة ) لا مناص من استخدامها في أية دراسة علمية، إنسانية كانت أم بحتة، طالما ندرك بأن كل ( معرفة ) لابد أن تولّد وتنمو وتتطوّر في ( إطار تاريخي ) لها، كما أنها لابد أن تفسر في ( إطار نفسي ) لها، إذ لا يمكن أن يحيا الشيء خارجاً من ( الزمن ) - ونعني به التاريخ - ولا يمكن أن تتمثّله البشرية خارجاً عن ( استجابة النفس ) له.
إذن: ما يطلق عليه مصطلح ( المنهج الموضوعي ) لا يتاح للناقد الأدبي أن يقتصر عليه إلاَّ في نطاق ضئيل بنحو ما سبقت الإشارة إليه. وخارجاً عن ذلك، فإن الضرورة العلمية تفرض على الباحث بتجاوزه إلى تخوم المعرفة التاريخية والنفسية، وسواهما من أدوات البحث العلمي، شريطة أن يتم في سياقات خاصة تظل بمثابة ( إنارة ) لا أكثر... وإلاّ فإن البحث لو تجاوز دائرة ( الإنارة )، فَقَد أصالته العلمية... كما أنه يفتقد أصالته في حالة جمود الباحث على ( المنهج الفني أو الموضوعي) دون توشيحه بالإنارة المشار إليها.
الاتجاه الاجتماعي:
هذا الاتجاه، يحاول دراسة النص الفني في ضوء الظروف الاجتماعية التي ولد النص فيها، بصفة أن النص ظاهرة اجتماعية لها أسسها ومكوّناتها وصلاتها بمختلف الصُّعد التي تفرزها.
إن القصيدة أو القصة أو الخطبة، مجموعة من أفكار وأشخاص ومواقف وأحداث في ( بيئة ) معينة، تتميّز من مكانٍ لآخر وزمانٍ لآخر، ولكل منهما طابع يختلف بالضرورة عن سواه، حينئذٍ فإن سلخ النص من دائرته الاجتماعية يجعل عملية ( التقويم الفني ) بتراء، لا تحقق الفائدة المستهدفة في النصّ.
وبعامة يمكن للناقد الأدبي أن يتوكأ على البعد الاجتماعي في دراسته للنص وفق مستويات متنوعة، منها: استثمار البعد الاجتماعي فكرياً، بمعنى أن الناقد حينما يتناول نصاً فنياً قديماً - على سبيل المثال - فإن الضرورة تفرض عليه أن يعتمد البعد الاجتماعي بمستويين من التناول:
أولاً : وضع النص في بيئته الاجتماعية التي عكست تأثيرها عليه، كما لو افترضنا أننا حيال ( خطبة ) سياسية، حيث يتطلّب الموقف عرض المناخ السياسي عصرئذٍ بما يواكب ذلك من ظواهر اجتماعية مرتبطة بالمناخ المذكور.
ثانياً : محاولة ربط الأفكار التي انتظمت الخطبة، بالواقع الاجتماعي الحديث الذي يحياه الناقد ؛ بصفة أن الكاتب الملتزم لا يمارس نشاطه النقدي المتمثّل في ( نصٍ قديمٍ ) لمجرد تزجية الوقت أو الإمتاع الفنّي، بل يختار النشاط النقدي وظيفة عبادية له. فإذا كانت دراسته للخطبة المذكورة تمثِّل فترة ( زمنية ) مندثرة، لا صلة لها بالواقع المعاصر، حينئذٍ يكون الناقد الإسلامي قد تخلّى عن مهمته العبادية. ولكنه حينما يصل بين دراسة الخطبة المشار إليها وبين واقعه الاجتماعي، مستثمراً ذلك لتوجيه مجتمعه وإصلاحه، يكون حينئذٍ قد أدّى مهمّته العبادية.
أما ما يتصل بدراسة النص من حيث صلته بالبيئة الاجتماعية التي نشأ فيها، فضرورة ذلك من الوضوح بمكان، مادامت الدلالة الفكرية التي يستهدفها الناقد الإسلامي تتطلب الوقوف على طبيعة الظواهر السياسية التي عالجتها الخطبة، حتى يمكن الإفادة من ذلك ( إيجاباً أو سلباً ) في
تعديل السلوك.
طبيعياً، الإفادة المذكورة تحقَّق - بطريق أولى - حينما يدرس الناقد الإسلامي نصاً معاصراً خلال طرحه في البيئة الاجتماعية التي أفرزته.
المهم، أن وضع النص في إطاره الاجتماعي أو التاريخي، يتمّ من خلال مستويات متنوعة - كما قلنا. فإذا تجاوزنا قضية استثمار البعد الاجتماعي وتوظيفه عبادياً، أمكننا أن نقرّر بأن ذلك يتطلّب التوفّر على مختلف المستويات الاجتماعية بالقدر الذي تستلزمه، وهو أمر يستتلي:
١ - تحقيق النص من حيث تصحيح نسبته إلى قائله، ومن حيث سلامته من التحريف أو الخطأ ونحوهما.
إن انتحال النص أو تحريف بعض فقراته، أو زيادته أو نقصانه.. يستتلي الوقوع في عملية ( تشويه ) للحقيقة، وهو أمر يتنافى مع الأمانة التي تطبع الشخصية الإسلامية.
٢ - وضع النص في جميع الأطر التي يشّع بها: ثقافياً، سياسياً، اقتصادياً، وجغرافياً... إلخ ؛ بصفة أن إهمال بعض الجوانب يدع الدراسة بتراء، حيث ينعكس ذلك على طبيعة التفسير الذي يستخلصه الناقد.
٣ - عرض النص على البيئة الاجتماعية، وعرضها عليه أيضاً حتى يضاء أحدهما بالآخر ؛ استكمالاً لصحة التفسير الذي يقدّمه الناقد الأدبي.
هذا فيما يتصل بالتفسير الاجتماعي.
أما ما يتصل بالتفسير الفنّي، فينبغي إخضاع النص ل- ( النسبية ) في التقويم ؛ بصفة أننا لا يمكننا أن نطالب الشاعر الذي يكتب القصيدة قبل ألف عام مثلاً، أو في حقبة تاريخية سابقة لعصرنا الحديث: لا يمكننا أن نطالبه بتصوراتنا الفنية المعاصرة، بل نتعامل مع النص بأدواته ومبادئه التي خبرها مجتمعُه. لكن لا يعني هذا أن يتخلّى الناقد عن معاييره الفنية الحديثة، وإلاَّ انتفت الحاجة إلى النقد أساساً، وأصبحت الدراسة مكرورة، تتحدّث بنفس المستوى الذي تحدّثت عنه دراسات متزامنة لعصر الشاعر، بل لا مناص للناقد من أن يستخدم المعايير الحديثة أيضاً، لكن من خلال اكتشافه للقيم الفنية والفكرية التي عجز القدماء من النقاد عن اكتشافها بحكم القصور الثقافي لديهم.
٤ - ( مقارنة ) النص المدروس مع نصوص أخرى سابقة أو متزامنة أو لاحقة عليه.
إن ( المقارنة ) بين النصوص المختلفة التي تحوم على ( الموضوع ) الذي نعتزم دراسته، من أهم عناصر البحث التاريخي ؛ بصفة أن مقارنة الشيء بما يماثله من جانب، وبما يضاده من جانب آخر، إنما تساهم في بلورة الموضوع وإنارة جوانبه بنحو تام. فعن طريق ( التماثل ) أو ( التشابه ) بين الأشياء، يمكننا أن نرصد الظواهر المشتركة بين ( موضوع ) الدراسة والموضوعات الأخرى، كما يمكننا عن طريق ( التضاد ) رصد الظواهر غير المشتركة فيها، طالما نعرف أن كثيراً من الموضوعات لا تبرز قيمتها إلاَّ
من خلال ( الضد ) لها.
فلو أردنا أن نتناول إحدى قصص القرآن الكريم مثلاً، ولتكن قصة ( أهل الكهف ) ؛ لملاحظة قيمتها الفكرية والفنية، للاحظنا أن مقارنتها بالقصص التي ( تماثلها ) وبالقصص التي ( تضادها )، سوف تساهم بتجلية المزيد من قيمتها. فمثلاً هناك في سورة الكهف أكثر من قصة تنتظم السورة المذكورة، منها: قصة صاحب الجنَّتين، وقصة ذي القرنين... القصة الأولى تتحدّث عن مُزارع يمتلك مزرعتين معيَّنتين، إلاَّ أن صاحبها لم يتسم بطابع الشخصية الواعية لمبادئ الإيمان، فنجدها قد ركبت رأسها، وخيَّل إليها أن المزرعتين سوف تحتفظان بحيويتهما ولن تبيدا أبداً، حتى حملها هذا الغرور على أن تشرك بالله.
بينا نجد أن القصة الأخرى ( قصة ذي القرنين ) تتحدّث عن بطلٍ مَلَكَ مشرق الدنيا ومغربها ( لا أنه مَلَكَ مجرد مزرعتين صغيرتين ) لكنه لم يحتجزه هذا المُلك عن السلوك العبادي المفترض عليه بقدر ما عمّق يقينه بالله، على العكس تماماً من صاحب الجنتين الذي ساقه مجرد الإشباع الضئيل إلى أن يستجيب حيال الله استجابة مرضية.
والآن، حينما نقوم بعملية ( مقارنة ) بين قصة أهل ( الكهف ) وبين هاتين القصتين، نجد أن ( المقارنة ) ستساهم بتجلية القصة الأولى وتعميق مفهومها للقارئ:
مثلاً أبطال الكهف يشكّلون نموذجاً للشخصية التي نبذت زينة الحياة الدنيا، بحيث تركوا كل أنماط المتاع الدنيوي واتجهوا إلى الله، من خلال اللجوء إلى أشد المواقع بعداً عن الحياة، وهو ( الكهف )، حيث هتفوا قائلين:( رَبّنَا آتِنَا مِن لّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً ) . لكننا حينما نقارن هؤلاء الأبطال - من خلال ( الضد ) - بصاحب الجنتين، نجد أن هذا الأخير يمارس سلوكاً مضاداً لأبطال الكهف، فإذا به يهتف:( مَا أَظُنّ أَن تَبِيدَ هذِهِ أَبَداً * وَمَا أَظُنّ السّاعَةَ قَائِمَةً ) أي أنه بدلاً من أن يتجه إلى الله كما فعل أصحاب الكهف، اتجه بدلاً من ذلك إلى ( الشيطان )، تشبثاً بزينة الحياة الدنيا، بينما نبذ أصحاب الكهف الزينة المذكورة كما لحظنا.
وأما لو قمنا بعملية ( المقارنة ) من خلال ( التماثل )، فحينئذٍ يمكننا أن نوازن بين أبطال الكهف وبين ذي القرنين، في تماثلهما من حيث الوعي العبادي. فهذا الأخير بعد أن هيمن على مشرق الأرض ومغربها، هتف قائلاً:( هذَا رَحْمَةٌ مِن رّبّي ) ، وأبطال الكهف حينما قرّروا اللجوء إلى الكهف هتفوا:( رَبّنَا آتِنَا مِن لّدُنكَ رَحْمَةً ) أي أن كليهما تعامل مع ( رحمة ) الله: ذلك من خلال التقرير، وهؤلاء من خلال الطلب.
إذن: حينما يتجه الدارس إلى عنصر ( المقارنة )، فيتوكّأ على الظواهر ( المتماثلة ) أو ( المتخالفة ) مع موضوع بحثه، إنما يسعف القارئ على تعميق إدراكه للموضوع، بالنحو الذي لحظناه في نموذج ( المقارنة ) القصصية.
والمقارنة يمكننا أن نتصورها على جملة أنحاء ، منها:
١ - المقارنة الموضعية.
٢ - المقارنة الشاملة.
٣ - الدراسة المقارنة المستقلة.
ويقصد بالأولى: المقارنة الجزئية التي تحوم على النص وعلاقته بالنصوص الأخرى لموضوع محدد، كما لو قارنا بين ديوان أحد الشعراء مثلاً بدواوينه الأخرى.
وأما المقارنة الشاملة، فتجاوز ذلك إلى الشعراء الآخرين، سواء أكانوا معاصرين للشاعر أم سابقين عليه أم لاحقين له.
وأما ( البحث المقارن ) فيشكل موضوعا نقديا مستقلا بذاته وليس عنصرا من عناصر النقد، وهذا من نحو ما إذا افترضتنا مثلاً قيام أحد النقاد بدراسة مقارنة بين الشعراء الإسلاميين في صدر الرسالة وبين الشعراء الإسلاميين المعاصرين... والفارق بين هذا النمط الأخير من المقارنة وبين النمطين الأولين - كما أشرنا - هو أن المقارنة فيهما تشكل واحدا من عناصر العمل النقدي، وأما النمط الثالث فيشكل موضوعا مستقلا...
إن ما نستهدف التشدد عليه هو: أن ( المقارنة ) بأنماطها التي عرضنا لها تشكل واحدا من عناصر النقد التاريخي أو الاجتماعي: له أهميته الكبيرة في ميدان التقويم للنص من خلال عرضه على البيئات الفنية المختلفة، بالنحو الذي تقدم الحديث عنه.
الاتجاه النفسي:
يقصد ب- ( الاتجاه النفسي): الطريقة التي يستخدمها الباحث في دراسته لأحد الموضوعات في ضوء الظواهر النفسية له، أي: إخضاع البحث للتفسير النفسي، متمثِّلاً في الركون إلى مختلف المبادئ التي يطرحها ( علم النفس ) في هذا الميدان.
وإذا أدركنا أن ( علم النفس ) يعنى بدراسة السلوك الإنساني من حيث ( استجاباته ) حيال ( المثيرات ) المختلفة التي يواجهها الشخص، أدركنا حينئذٍ أهمية هذا الضرب من المعرفة من حيث انعكاساته على النص المدروس.
ولعل أهم ما يميّز البحوث المعاصرة هو: توسّلها بهذا الفرع من ( المعرفة ) التي وجدت طريقها إلى الظهور مع إطلالة القرن الحديث. طبيعياً، لا يعنينا أن هذا النمط من المعرفة مصحوب - مثل سائر الضروب المعرفة الإنسانية المنعزلة عن مبادئ السماء - بمفارقات علمية لا يمكن الركون إليها في تفسير الظواهر، إلاَّ أن ذلك لا يحتجز الباحث الإسلامي من الإفادة منه واستثمار الكثير من معطياته العلمية التي واكبها جانب من الصواب دون أدنى شك.
المهم، أن الكاتب الإسلامي - في ضوء وعيه العبادي - يمكنه أن يفرز بوضوح بين ما يمكن أن يفيد منه في دراساته العلمية ونبذ ما سواه... والمهم أيضاً أن يكون توسله بهذا الضرب من المعرفة، مفضياً إلى إلقاء مزيد من الإنارة على النص، واكتشاف مختلف دلالاته التي تظل غائمة - دون أدنى شك - لو اقتصر الباحث على البعد الفني والتاريخي لها فحسب... فلو افترضنا أن الباحث الإسلامي قد اعتزم أن يدرس ظاهرة ( الغناء ) ومعرفة الأسباب الكامنة - بعضاً أو كلاًّ - وراء حظر الشريعة الإسلامية لهذا النمط من الظواهر، حينئذٍ يمكنه أن يقصر بحثه على الدلالة الفقهية لها - أي يحصر البحث في صعيد المبادئ الفنية للموضوع -، كما لو استدل على ذلك بمجموعة من الروايات الحاكمة بتحريم ( الغناء)... كما يمكنه - مثلاً - أن يتجاوز ذلك إلى ( المنهج التاريخي ) فيعرض لظاهرة ( الغناء ) من حيث المناخ الاجتماعي الذي ألِفَ هذه الظاهرة، واقترانها بمجالس الشرب أو الاختلاط بين الجنسين ونحوهما. ثم تطوّر ذلك
من خلال تأثره بالتيارات الوافدة عصرئذٍ - أي القرنين الأولين من بزوغ الإسلام - وانعكاساتها على المجتمع المذكور، وصلة ذلك بنمط من الأشكال الصوتية التي لم يرد نهي إسلامي عنها أو ندب إليها مثل... الحدر والترتيل وسواهما.
أقول: من الممكن أن يقتصر الباحث في دراسته المذكورة على استخلاص الحكم الشرعي لظاهرة ( الغناء)، ويمكنه أيضاً أن يتوسّل بالبعد التاريخي له، فيقدّم حينئذٍ مزيداً من الإنارة على الموضوع. ولكن لو اتجه الباحث بعدئذٍ إلى ( المعرفة النفسية)، لأمكنه أن يلقي الأضواء الكاملة على الظاهرة، معمِّقاً بذلك إدراك القارئ لأهمية التحريم الإسلامي ( الغناء).
فمثلاً يمكنه أن يوضح طبيعة البناء العصبي للشخصية، وصلة ذلك باستجابتها حيال ( المنبِّهات ) الصوتية التي تنتظم في طبقات مركبة من هذا الإيقاع أو ذلك. كما يمكنه أن يستعين بالدراسات التجريبية التي انتهت إلى تحديد صلة ( الغناء ) أو ( الموسيقي ) بعامة بجملة من الأمراض النفسية والعقلية والجسمية مثلاً. وحينئذٍ ستتَّسم دراسته بمزيد من الأهمية التي لا يمكن الظفر بها لو كان الباحث مقتصراً في دراسته للغناء على مجرد البعد الموضوعي والتاريخي له.
والامر ذاته فيما يتصل بظاهرة القمار مثلاً، حيث يمكن للباحث أن يستعين ب- ( المعرفة النفسية ) لتفسير سلوك ( المقامر )، من حيث كونه شخصية شاذة منحرفة، عدوانية متصارعة، متمزِّقة متوترة... إلخ.
إذن: الاستعانة بالمعرفة النفسية تظل أشد الأبعاد أهمية في إنارة الموضوع وتعميق دلالاته المختلفة... فضلاً عما تنطوى عليه من إثارة وتشويق يسهمان في دفع القارئ إلى متابعة الموضوع وتمثُّله.
ويمكننا أن نفيد من البُعد النفسي في جملة من الميادين ، منها:
١ - دراسة الموضوع - أو النص - في ضوء صلته بكاتبه . ويقصد بذلك: أن الناقد الأدبي يتعيّن عليه - في سياقات خاصة - أن يربط بين النص المدروس وسلوك كاتبه، من حيث انعكاسات سلوكه على النص، حتى تتضح دلالاته بنحو أشد عمقاً في هذا الصدد.
بَيْد أن أمثلة هذا الاستعانة بالبعد النفسي تنطوى على مزالق كثيرة ينبغي أن يظل الباحث على حذر شديد منها، بخاصة إذا عرفنا - أولاً - أن النصوص لا تعدّ في الحالات جميعاً ( وثيقة ) مفصِحة عن نفسية كاتبها، بقدر ما تعد عملاً (موضوعياً) ينفصم فيه الشخص عن نتاجه الفنّي. فقد نقرأ قصيدة - مثلاً - تتحدّث عن ( الشجاعة ) إلاَّ أن صاحبها موسوم بالجبن، وقد يتحدّث ( الخطيب ) عن أهمية الصدق إلاَّ أنه يمارس ( الكذب)... إلخ، مما يعني أن الباحث ليس بمقدوره أن يستخلص عن النص المدروس حقيقة السلوك الذي يصدر عن كاتبه، مادام النص غير مفصح بالضرورة عن كونه وثيقة عن نفسية صاحبه.
أما المفارقة الأخرى التي تترتّب على ربط الصلة بين النص وسلوك كاتبه، فتتمثّل في صعوبة
تشخيص الدلالة النفسية ذاتها... فمثلاً إذا افترضنا أن أحد الأشخاص كان معتزماً لأن يكتب أو يتلفّظ بعبارة ( العلماء )، فكتبها أو تلفّظ بها بعبارة ( العملاء )، حينئذٍ لا يمكننا أن نرتّب أثراً نفسياً على هذه العبارة من النص المدروس، مادمنا غير واثقين بأن العبارة المذكورة قد عبّرت بالفعل عن ( سلوك لاشعوري ) حيال العلماء. من الممكن أن يكون صاحب النص ذا تركيب نفسي شاذ بالنسبة لنظرته عن ( العلماء )، بحيث قفزت عن لاشعوره، العبارة التي تختزنه أعماقه بالفعل، ونعني بها ( العملاء)، إلاَّ أن اليقين بذلك أمر لا سبيل إليه ؛ نظراً لتماثل مخارج الأصوات في العبارتين المذكورتين، بحيث نتوقّع أن يكون الخطأ المذكور ناجماً من الحقيقة الصوتية المذكورة وليس من اللاشعور.
إذن، وصل النص بنفسية كاتبه لا يعد من الحالات جميعاً عملاً ذا قيمة، مادمنا نعرف أن تشخيص ذلك لا يتم بسهولة، بل لابد من أن يمتلك الباحث مقدرة علمية متنوّعة، تتصل ليس بثقافته النفسية فحسب، بل بسائر أدوات الفن التي انطوى عليها النص المدروس.
هذا، إلى أن الباحث الإسلامي حينما يتوسل بالأداة ( النفسية ) في دراسة النص، يضع في اعتباره جانباً من الأهمية بمكان كبير، هو: أن كثيراً من النصوص لا يمكن البتة دراستها في ضوء الصلة بمبدعها، وهذا من نحو دراسته للنصوص القرآنية الكريمة مثلاً، أو دراسته للنصوص الواردة عن أهل البيتعليهمالسلام ؛ نظر لتنزّه الله تعالى عن ذلك، وعصمة أهل البيت عن الخطأ وسائر الفعاليات التي تصدر عن البشر العادي.
إنه من الممكن - فيما يتصل بالنصوص الواردة عن أهل البيتعليهمالسلام - أن يصل الباحث بينها وبين نفسيتهمعليهالسلام من حيث استخلاص السلوك السوي الصادر عنهم وانعكاساته على النص، إلاَّ أن ذلك يظل في مجالات محددة، بخاصة إذا عرفنا أن وصل النص بكاتبه يقترن - في غالبية الدراسات - باستخلاص الظواهر السلبية، وهمعليهالسلام معصومون من ذلك دون أدنى شك.
على أية حال، خارجاً عن المزالق الثلاثة التي أشرنا إليها، من المفيد جداً أن يتوكأ الباحث العلمي على هذا النمط من الوصل بين الموضوعات وأصحابها ؛ نظراً للأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها مثل هذه الاستعانة بالبعد النفسي... فإذا افترضنا أن أحد الشعراء - مثلاً - طالبَ في قصيدة له بتمزيق جثة الميت والتمثيل بها، أو أن أحد الأشخاص مارس عملية ( التمثيل ) بعدُوِّه... حينئذٍ فإن وصل القصيدة بنفسية صاحبها أو عملية التمثيل بممارسها، يظل من الأهمية بمكان، حيث يستخلص الباحث من ذلك أن الشاعر أو القاتل يحمل نزعة عدوانية يتلذّذ بتعذيب الآخرين، وإلاَّ فإن مجرد القتل كافٍ بتحقيق الغرض الذي استهدفه الشاعر أو القاتل، وهو التخلّص من العدو. أما أن يصحب ذلك ( تمثيل ) بجثته أيضاً، فيعد مؤشراً لمرض الشخصية وشذوذها ومعاناتها لمختلف الاضطرابات النفسية.
ومن البيّن أن اكتشاف الباحث العلمي للحقيقة النفسية المذكورة، تلقي مزيداً من الضوء على دقائق الموضوع وتفصيلاته التي لم تكن لتتضح بجلاء، لو لم يسلّط عليها الضوء النفسي المذكور.
٢ - دراسة النص وعلاقته بالجمهور . ثَمَّة فرع من العلوم النفسية يسمّى ب- ( علم نفس الجمهور )، وهدف هذا الضرب من المعرفة هو، دراسة الأساليب النفسية التي ينبغي أن تصاغ بنحو تترك تأثيرها في المتلقّي، مادمنا نعرف بأن التركيبة البشرية ذات استعداد معين لمختلف الاستجابات، تبعاً للطريقة التي ينتخبها الباحث أو المصلح أو الخطيب مثلاً.
من هنا نجد أن علماء النفس طالما يخطّطون هذا الأسلوب أو ذاك، بغية التأثير على نفسية الجمهور، سواء أكان ذلك في ميدان الصحة النفسية، أو الميادين الأخرى المتصلة بالسياسة والاقتصاد والاجتماع، وسواء أكان ذلك مقترنا بهدف ايجابي أو سلبي. ولعل ما يصطلح عليه ب- ( الحرب النفسية ) مثلاً، يعد نموذجاً واحداً من أشكال هذا الضرب من المعرفة، التي تعنى بتحديد العلاقة بين المنبّه والاستجابة، وصياغتها وفقاً لِما ينطوي عليه هذا الهدف أو ذاك من انعكاسات سلبية على الجمهور.
وبالمقابل، فإن الانعكاسات الايجابية تأخذ طريقها أيضاً في هذا الميدان، من نحو دراسة مختلف الأساليب التي تساهم في تعميق دلالة الخير في النفس الإنسانية، أو في توصيل دلالة النص الفني أو العلمي إلى المتلقّي... وهذا المنحى الأخير من الدراسة، أي: دراسة عملية التوصيل الفني والعلمي، يظل في الصميم من مهمة الباحث، مادام الباحث معنياً بدراسة النصوص أو الموضوعات وفقاً لانعكاساتها على الآخرين.
ولنأخذ مثلاً على ذلك:
لقد استهدف القرآن الكريم في إشارته للإبداع الكوني تعميق الدلالة المذكورة فنِّياً، فبدأ في سورة الملك - مثلاً - بلفت أنظارنا إلى خلق السماوات:( الّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماوَاتٍ طِبَاقاً مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرّحْمنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ ) . هذه الآية لو دقّقنا النظر فيها، للحظنا أن دراستها في ضوء قوانين التفكير البشرى، أي: طبيعة الآلية الذهنية من حيث استجابتها لعملية ( التعلّم ) مطلقاً، سوف تسعفنا على فهم الكثير من أسرارها... فمن الواضح أن عملية التفكير تبدأ ( في بعض قوانينها ) من ( المجمل ) إلى ( المفصّل)، أو من ( الكل ) إلى ( الجزء )، فأنت حينما تفتح صفحة من الكتاب مثلاً، إنما تتصورها ( كلاّ )، ثم تبدأ بتشخيص سطورها، ثم العبارات، ثم، الحروف... وقد يحدث العكس، تبعاً للموقف، فتبدأ من الحروف إلى الأسطر إلى الصفحة.
ولو عدنا إلى الآية الكريمة، للحظناها بادئة بمجمل الإبداع المذكور، وهو( سَبْعَ سَماوَاتٍ طِبَاقاً ) . ثم يفرز هذه السماوات من حيث علاقتها واحدة بالأخرى، متمثّلة في ( عدم التفاوت ) بينها:( مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرّحْمنِ مِن تَفَاوُتٍ ) . ثم بفرز السماء الواحدة من حيث عدم مشاهدة ( الشقوق )
فيها:( هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ ) ، وهذا يعني أن الآية الكريمة أخذت بنظر الاعتبار قوانين التفكير أو الاستجابة التي تبدأ من المجمل أو الكل ( مطلق السماوات)، إلى تفصيلاتها الأولية ( عدم التفاوت )، إلى تفصيلاتها الثانوية ( عدم الفطور ).
ومن الواضح أن الناقد حينما يدرس النص في ضوء الحقيقة التي أشرنا إليها، إنما يكشف عن جوانب أخرى من الإعجاز الفني في القرآن الكريم، مثلما يكشف عن حقائق ( الاستجابة الذهنية ) وقوانينها.
والامر ذاته فيما يتصل بالكشف عن قوانين ( الاستجابة النفسية ) من حيث عناصر ( التشويق ) و( الإثارة ) وغيرها، ممّا نلحظه في القصص القرآني الكريم مثلاً، أو ما نلحظه في بناء السورة القرآنية الكريمة من حيث مقدمتها وخاتمتها، حيث تبدأ السور الكريمة بطرح دلالات معينة بنحو تجعلنا نتهيَّأ نفسياً لتقبّل ومعرفة ما تتضمّنه من أهداف وأفكار متنوّعة.
٣ - دراسة النص الأدبي في ضوء الظواهر النفسية العامة . يقصد ب- ( الظواهر النفسية العامة ): دراسة النص من حيث انطوائه على دلالات نفسية محدّدة، بغض النظر عن ارتباطها بسلوك الفنان أو المتلقّي، بل بما هي ظواهر يمكن إخضاعها لقوانين عامة. فإذا اعتزم الناقد دراسة عنصر فنّي، مثل ( التشبيه ) في الأعمال الشعرية، ومثل ( الحوار ) في الأعمال القصصية، حينئذٍ يمكن دراسة هذه الجوانب في ضوء ما ينطوي ( التشبيه ) أو ( الحوار ) عليه من دلالات نفسية، مثل انتقاء عنصر مشترك بين طرفي الصورة وكون ذلك أما حسيِّاً أو تجريدياً، ومثل كون ( الحوار الداخلي ) - مثلاً - أشد صدقاً من غيره في التعبير عن أسرار النفس... وهكذا.
المهم أن دراسة النص في ضوء دلالاته النفسية، يظل من أشد مستويات البحث النقدي بالقياس إلى غيره من المعرفة الإنسانية، بخاصة إذا أدركنا بأن المنهج القائم على ربط الصلة بين النص وصاحبه لا يمكن الاطمئنان إليه. وأما المنهج القائم على ربط الصلة بين النص والجمهور، فمن الممكن أن يندرج ضمن دراسة النص في دلالاته النفسية، ممّا يعني - في نهاية المطاف - أن المنهج المذكور يظل أشد فاعلية من سواه، بالنحو الذي فصلّنا الحديث عنه.
البلاغة والنقد
البلاغة: مصطلح يطلق على أحد ضروب المعرفة المنتسبة إلى الموروث الأدبي القديم ( عربياً وأعجمياً)، وهو يتضمّن مجموعة من القواعد أو المبادئ التي ينبغي توفّرها في التعبير الأدبي ليكتسب جماليته الخاصة.. بَيْد أنّ هذا الضرب من المعرفة الذي اكتسب طابعاً استقلالياً في الموروث الأدبي، بدأ يضمر أو يختفي إلى حدٍ كبير في الأدب المعاصر، وبدأ ( النقد الأدبي ) يحتفظ لنفسه بهذه المهمة، ونعني بها: صياغة المبادئ أو القواعد التي ينبغي توفُّرها في التعبير الجميل، حيث يضطلع ما يُطلق عليه اسم ( النقد النظري ) بالمهمة المشار إليها، وهي مهمة تندرج ضمن عنوان عام هو ( نظرية الأدب )، الشاملة لعمليات (التنظير ) للظواهر الأدبية. مقابل ( دراسة الأدب وتاريخه )، الشاملة لعمليات ( التطبيق ) للظواهر المشار إليها.
إن ما نعتزم توضيحه في هذا الحقل هو: أن ( البلاغة ) في طابعها الموروث، تظل مثل غالبية ضروب المعرفة، محكومة بسمة العصر الذي ولدت في نطاقه، حيث ترتد بجذورها إلى أكثر من ألف عام، شهدت الأجيال الأدبية من خلالها تطوُّرات ملحوظةً في حقل الأدب وقواعده الفنية، بحيث لم تعد ( البلاغة ) منسجمةً مع التطورات التي أشرنا إليها. بل يمكن القول بأن الجمود والقصور والتكلّف تظل من أبرز سمات ( البلاغة ) القديمة بالقياس إلى أدوات النقد الأدبي المعاصر.
فالبلاغة - من جانب - تظل محدودة القواعد، لا تتجاوز صعيد الأشكال الأدبية التي خبرتها القرون الأُولى، مثل الشعر العمودي والخطبة والرسالة وما إليها، في حين أن الأشكال الأدبية المعاصرة - وفي مقدمتها القصة والمسرحية بكل مستوياتها - لا تخبر البلاغة أي شيء من مبادئهما: مع أن هذين الشكلين الأدبيين، يُعدّان من أكثر الفنون التعبيرية إثارةً وانتشاراً وتأثيراً في النفوس، ويكفينا أن نجد أن القرآن الكريم يعتمد الشكل القصصي بنحو ملفِت للنظر ،مما يفصح عن أهمية وخطورة الشكل الأدبي المذكور.
والغريب أن البلاغة الموروثة
بالرغم من أنها قد توفّرت على أدق التفصيلات المتصلة بظواهر ( المعاني ) أو ( البديع ) إلى درجة التخمة الممقوتة، لم تتوفّر على دراسة العنصر القصصي في القرآن الكريم، مع أنها ساهمت في دراسة النص القرآني في تبيين وجوه الإعجاز المختلفة فيه، حيث ظلت هذه المساهمة في صعيد القواعد الموروثة. علماً بأن البحث عن الإعجاز القرآني يتطلّب دراسة مختلف أشكاله التعبيرية.
طبيعياً أن غياب العنصر القصصي من ميدان اللغة العربية وآدابها، يفسّر لنا غياب الدراسة البلاغة للإعجاز القصصي في القرآن، إلاَّ أن الكثير من القواعد البلاغية الموروثة، قد تأثّرت - خلال الترجمة من آداب الأغارقة - بمفهومات الأغارقة، مثل: فنّ الخطابة، وفن الشعر المسرحي، بل مطلق العمل القصصي وجد له طريقاً - من خلال الترجمة - إلى آداب اللغة العربية آنذاك.
لكن فيما يبدو أن العمل القصصي والمسرحي بما أنه قد اقترن بالفكر الوثني، حينئذٍ من الممكن أن يشكّل ذلك حاجزاً عن التوفّر على دراسة مبادئه. لكن مع ذلك، كان من الممكن أن تنبثق نظرات ( إبداعية ) - ولو في نطاق محدّد جداً - عن فنّ الإعجاز القصصي، لولا انعدام الثقافة القصصية التي لا تسمح بأية محاولة إبداعية في هذا الصدد. مضافاً إلى أن وجوه الإعجاز المختلفة التي اكتشفها الدارسون آنذاك، كافية في صرفهم عن المزيد من البحث عن وجوه أخرى لم يمتلكوا أدواتها الثقافية.
إذاً تظل البلاغة الموروثة محدودة المبادئ من جانب، كما أنها من - جانب آخر - تظل حتى في نطاق الأشكال الأدبية التي توفّرت عليها، ذات نظرة ( تجزيئية )، تتناول أجزاء العمل الأدبي دون أن تقرنها ب- ( وحدة ) العمل المذكور، أي أنها تقتصر على ما هو ( جزئي ) فحسب، دون أن تتناول ما هو ( كلّي). إنها تتحدّث عن عناصر من نحو: ( التقديم، التأخير، الحذف... إلخ ) بالنسبة إلى ( المعاني )، وتتحدّث عن ( التشبيه أو الاستعارة... إلخ ) بالنسبة إلى ( البيان )، وتتحدث عن ( التقابل أو التجانس... إلخ ) بالنسبة إلى ( البديع )... لكنها لا تتحدّث عن هذه العناصر من حيث كونها منتسبة إلى ( وحدة ) كليّة تنتظمها. وإذا استثنينا ما يطلق عليه مصطلح ( الاستهلال ) و( التخلص ) و( الختام )، حيث يرتبط هذا المفهوم بهيكل النص، وهو مفهوم مبتسر وغائم لا يحدّد الفوارق بين أشكال النص الأدبي، حينئذٍ لا نعثر على أية مبادئ فنية تتناول هذا الجانب.
وحتى في نطاق ما يتناول ( جزئياً )، يظل التناول المذكور أما شكلياً لا غناء فيه، أو سطحياً لا عمق فيه، أو متكلِّفاً لا حيوية فيه، أو عميقاً لكن لا فائدة فيه.
والأهم من ذلك أن طبيعة العصر الذي ولدت البلاغة في نطاقه، لا تسمح لمبادئها الفنية أن تتجاوز تخوم العصر وتخترقه إلى عتبة العصر الحاضر مثلاً ؛ لأن المطالبة بذلك يظل أمراً غير مقبول البتة. لكن من غير المقبول أيضاً أن نجمد - نحن المعاصرين - على قواعد فنية فرضتها طبيعة القرون الأُولى، ولا نسمح لأنفسنا بالخضوع إلى قواعد العصر الذي نحياه.
لذلك ليس من المعيب أن تتسم البلاغة الموروثة بالطوابع التي أشرنا إليها، مادامت نابعة من طبيعة القصور الفني الذي يطبع القرون الوسطى. إلاَّ أن المعيب هو: أن نعطّل إمكاناتنا الثقافية ونشدّها بعجلة القرون الأًولى(١) . وأياً كان، فإن المهمّ هو أن نعرض لهذا الجانب من خلال التصوّر الإسلامي.
إن نصوص القرآن الكريم والنصوص الفنية الواردة عن أهل البيتعليهمالسلام ، تتميّز بكونها نصوصاً مطبوعة بسمتي ( الخاص والعام )، أي أنها ترشح بإمكانات يفيد منها كل جيل بحسب الثقافة التي تغلّف الجيل المذكور. إنها تتضمّن وجوهاً إعجازية وفنّية خبرتها القرون الوسطى بحسب ما تمتلكه من مبادئ وقواعد فنية، من نحو مستويات التشبيه والاستعارة والكناية مثلاً. لكنها في الآن ذاته - أي النصوص الشرعية - تتضمّن وجوهاً إعجازية لم تخبرها تلكم القرون، بل جاء العصر الحديث وخبرها بما يمتلكه من أدوات الثقافة النفسية والاجتماعية والعلمية بنحو عام، فدرسها في ضوء خبراته الجديدة.
وهذا من نحو الدراسات التي تناولت العنصر القصصي في القرآن، حيث أشرنا إلى أن البلاغة الموروثة نسجت صمتاً كاملاً حيال العنصر المذكور ؛ نظراً لعدم امتلاكها للثقافة القصصية التي فرزتها بيئات أخرى قديماً وحديثاً. فلو سمحنا لأنفسنا بالجمود على البلاغة الموروثة، لَما أمكننا أن نُقدّم أي جديد من وجوه الإعجاز القرآني، ومن ثَمَّ لم نقدّم إسهاماً في نشر المعرفة الإسلامية.
إن تضمّن النص القرآني مختلف أوجه الإعجاز، الذي يتخطّى ما هو خاص إلى ما هو عام، يفرض على الدارس الحديث أن يكتشف الأوجه المذكورة من خلال أدواته الحديثة التي يمتلكها عصره. ويظل العنصر القصصي واحداً من النماذج التي حرصنا على إبرازه، بصفته مجرد نموذج للتدليل على أهمية التوسّل بأدوات العصر لتبيين الوجوه الإعجازية فيه، وضرر الجمود على أدوات القرون الأولى.
والامر نفسه بالنسبة إلى بناء النص القرآني من حيث كونه ( سورة )، لها بداية ووسط ونهاية، روعي فيها تخطيط محدّد بالنسبة إلى توصيل الأفكار إلى الجمهور بما هو أشد إثارة وتعميقاً.
فالتوسل بأدوات المعرفة الحديثة بالنسبة إلى طرائق الاستجابة البشرية وما يرافقها من العمليات الذهنية، يسعف الدارس على اكتشاف وجوه الإعجاز القرآني في بناء السورة، والتخطيط لموضوعاتها وفق عمليات النموّ والتلاحم والتوازي والتقابل الهندسي لها.
وحتى بالنسبة إلى التناول الجزئي للنص، مثل الصورة أو الإيقاع أو المرأى أو الموقف، بمقدور الدارس الذي يتوسل بأدوات الفن الحديث أن يكتشف وجوه الإعجاز القرآني، أو السمات الفنية التي تتضمّنها خطب أو رسائل أو أحاديث أهل البيتعليهمالسلام .
وهذا كله فيما يتصل بمهمة الدارس للنصوص الشرعية.
أما ما يتصل بمهمة الفنان، قاصاً أو مسرحياً أو شاعراً أو خطيباً، فإن التوسّل بأدوات الفن الحديث يرشّحه للنجاح في أداء مهمته الإسلامية، طالما يواجه جمهوراً له مناخه الأدبي الذي يحياه. وهذا على العكس من التوسل بأدوات البلاغة الموروثة، حيث يعزل الفنان عن جمهوره ويدمغه بطابع التخلّف الفني، فضلاً عن أنه يقدّم نتاجاً رديئاً متكلّفاً ممقوتاً، لا يؤدّي المهمة الإسلامية التي استهدفها في نتاجه المشار إليه.
من هنا، فإن التوفّر على بلاغة حديثة يفرض ضرورته على ميدان الفن الإسلامي، سواء أكان ذلك في نطاق الدراسة الأكاديمية ( الجامعة والحوزة )، أو نطاق التعلّم لآداب لغة القرآن، أو نطاق الدراسة الأدبية ( دراسة النصوص الإسلامية )، أو نطاق الأعمال الإبداعية ( قصة مسرحية، قصيدة، خطبة، خاطرة، مقالة.. ).
وإذا كنّا - في الكتاب الذي نقدّمه - قد ألممنا بمجمل التصور الإسلامي لمبادئ الفن(١) ، وهو ما نعنيه بالبلاغة الحديثة، فإن المطلوب من سائر الدارسين أن يتوفّروا على هذه المبادئ بنحو مفصّل، لتشكّل خطوطاً لقواعد الفن، بدلاً من القواعد البلاغية الموروثة بالنحو الذي تقدّم الحديث عنه.
تاريخ الأدب والفنّ
قلنا إن الدراسة ( الوصفية ) للفنّ أو الأدب تنتظمها ثلاثة حقول هي: نظرية الأدب ، نقد الأدب، تاريخ الأدب.
وقد مرّ الحديث عن كلّ من (نظرية الأدب ونقده)، فيما نحاول الآن الوقوف عابراً على الحقل الثالث، وهو: ( تاريخ الأدب أو الفنّ ).
إن تأريخ الأدب أو الفنّ من الممكن أن يدرج ضمن التأريخ العام للمجتمعات والأمم أو الدول، من حيث نشأة الفنّ وتطوره وانعكاس المؤثّرات التاريخية عليه بم-ختلف أبعادها: سياسياً، اجتماعياً، اقتصادياً.. إلخ. بَيْد أن الفارق بين ( لتأريخ العام ) و( تاريخ الأدب أو الفنّ ) هو: إبراز الجانب الفني من النصوص المدروسة، اي: إبراز القوانين أو المبادئ الفنية التي نشأت بهذا النحو أو ذاك، ثم تطورها أو تغييرها ضمن السلسلة الزمنية التي تؤرّخ لها، بما يواكب هذه النشأة أو التطور أو التغيير أو الانحطاط من مؤثرات تاريخية سحبت آثارها على ذلك.
طبيعياً، من الممكن أن تتنوّع الطرائق التي تؤرّخ للأدب أو الفنّ، بحيث تدرس ( الموضوعات ) حيناً، أو ( الأدباء ) حيناً آخر، أو ( القواعد الفنية ) حيناً ثالثاً. بَيْد أن المهم هو أن يظل ( البعد الفني ) هو العنصر المستهدَف في تاريخ الأدب، وليس ( الأدب ) بصفته مجرد ظاهرة معبِّرة عن حركة التأريخ، وإلاَّ ينتفي الفارق بين التأريخ العام وتاريخ الأدب.
أما إسلامياً: فإن النشاط المتصل بتأريخ الأدب والفن، ينبغي أن يتحدَّد بمنهج خاص يأتلف مع المهمة العبادية للباحث الملتزم، لكن: اعتاد مؤرِّخو الأدب في البلاد الإسلامية دراسته وفق تصوّر خاص، لا يلتئم مع الواقع الإسلامي الذي ينبغي أن نتحرّك من خلاله في نظرتنا للأدب وتاريخه. إنه لمن المؤسف أن نلحظ مستويات التعليم الثانوي والجامعي وسائر مؤسسات التعليم الرسمي، تخضع لمعايير غير إسلامية في تنظيم مناهج الدراسة. ولعلّ أبرز هذه المناهج - غير الملتئمة مع الواقع الإسلامي - هو: المنهج الذي يدرِّس الأدب وفقاً لعصوره التاريخية، وهي عصور تخضع للمعيار القومي قبل خضوعها للمعيار الإسلامي، كما أنها
تخضع لعصور سياسية ( منحرفة ) عن الإسلام، واإن كانت تحمل اسم ( الإسلام )، ولكنّها لم تفرز في الواقع إلاَّ حفنة من (الحكّام ) الذين تسلّطوا على شعوبهم، وأذاقوهم مختلف الشدائد، فضلاً عن أن الترف والمجون واللهو والابتزاز، كان هو الطابع للحكام المذكورين، على نحو ما نلحظه في حياتنا المعاصرة من حكّام يحملون اسم الإسلام إلاَّ أنهم ( منحرفون ) عنه، مشدودون إلى أنظمة أوربية لا علاقة لها بالإسلام.
المهم، أن دراسة الأدب وفق تقسيمه السياسي للعصور، يظل في مناهج التعليم الرسمي جزءاً من الأنظمة المنحرفة عن الإسلام، ممّا ينبغي أن ننتبه عليه في غمرة محاولتنا لتخطيطِ تصوّرٍ إسلامي للأدب ودراسته، بخاصة ونحن مقبلون على أبواب ثورة إسلامية تجتاح مختلف بقاع الأرض، واستلزامها - من ثَمَّ - تنظيماً خاصاً لمناهج الأدب، مستقى من واقع الإسلام لا سواه.
وإذا كان تطبيق المنهج الإسلامي لدراسة الأدب وتاريخه، يرتطم ببعض الصعوبات، بخاصة من قبل الأنظمة الرسمية، فإن محاولة دراسته عبر مؤسسات أهلية أو حكومة إسلامية حقّة، مثل: جمهورية إيران الإسلامية... مِثْل هذه المحاولة لا مناص لنا من تثبيتها ولفت أنظار المسئولين الإسلاميين إليها، وإلاَّ فإننا نتحمل مسئولية الصمت حيال مناهج البحث الأوربي، التي لا تزال - مع الأسف - متحكّمة، ولو من حيث الطابع العام، في بعض الأجهزة الإسلامية التي لم تنتبه لحدّ الآن على هذا الجانب.
خذ على ذلك مثلاً: دراسة ( الأدب الجاهلي )... لا تكاد جامعة من جامعات الدول الإسلامية ( ومثلها: التعليم الثانوي )... تعزل هذا العصر السياسي عن العصور الإسلامية، بل تجعله أوّل عصور الأدب، فيما تسلّط الإنارة عليه بنحو ما تتعامل من خلاله مع سائر عصور الأدب. لقد جاء الإسلام ليضع حدّاً للعصر الجاهلي بتفكيره الوثني، وبأعرافه وتقاليده التي لا تنسجم مع مبادئ الإسلام. إلاَّ أن مؤرّخي الأدب يغمضون أعينهم عن هذا الجانب ويدرسونه بلا أي تحفُّظ، إلاَّ نادراً. والسر في ذلك، عائد - في المقام الأول - إلى العصب القومي الذي غذّاء الاستكبار العالمي، بعد أن وجدان ( العصب الجاهلي ) لا يزال متحكّماً في النفوس.
مؤرِّخو الأدب ينظرون إلى الأدب وتأريخه من منظار ( عربي ) وليس من منظار ( إسلامي )... فالجاهليون ( عرب ) قبل كلّ شيء، ولذلك لابد من دراسة آدابهم. أما ( الإيمان )، فلا يعنون به. لقد سئل الإمام عليعليهالسلام عن وجهة نظره بالشعر، فأشار إلى ( الملك الضِّلِّيل ).. إلاَّ أن مؤرّخي الأدب يتدارسون شعره بكلّ ما فيه من قيم غير إسلامية ( جنس وخمر و... إلخ)، ولا تعنيهم
ضلالة ( امرئ القيس )، بل يعنيهم ( شعره العربي )، وهذا هو سرّ المأساة.
لا أعلم كيف نسمح لأنفسنا بمدارسة قصائد القيس وطرفة وسواهما، بما تنطوى عليه من ( عصبيّات )، وبما تنطوى عليه من تقاليد ( في تناول الخمر )، وأعراف ( من ممارسة الجنس). فضلاً عن ( الفكر الوثني ) الذي يشيع في تضاعيف هذه القصيدة أو تلك. لا أعلم كيف نسمح لأنفسنا بمطالبة المنتسبين للمؤسسات الثانوية والجامعية بحفظ هذه القصائد وإفساد أذهانهم بها، وإرهاق أعصابهم بقراءتها، وتضييع أوقاتهم الثمنية التي ينبغي أن يستثمروها - في العمر القصير - بممارسة العمل العبادي الذي ( وظّفنا ) من أجله... كيف نسمح لأنفسنا - نحن المعنيّين بشئون الأدب الإسلامي - بإضلال الطلاّب وإفسادهم بهذا النمط من الأدب المفروض على مناهج الدراسة ؟! إنها لمسئولية ضخمة، لابدّ للمهتمين بمناهج الدراسة من الالتفات إليها.
طبيعياً، أنه من الممكن مثلاً أن يشير ( الدارس ) إلى محتويات الأدب الجاهلي، ويلفت انتباه الطالب إلى قيمه ( المنحرفة)، وبمقدوره أيضاً أن يركّز على تقاليده ( المباحة )، أو يلفت الانتباه إلى بعض ( الومضات ) الخيّرة التي تشع في قصائد بعض الشعراء فيما يتصل ب- ( الحنيفية)، وفيما يتصل ب- ( التوحيد )، وفيما يتصل بالإشارة إلى ( المبدع). وهكذا فيما يتصل ببعض ( الخُطب ) الفنية التي تتضمن بعداً دينياً... أقول: بمقدور الدارس أن يركّز على نصوص أدبية وجدت هنا وهناك على لسان بعض الشعراء والخطباء عصرئذٍ... إلاَّ أن هذه النصوص ضئيلة ( الكم ) بالقياس إلى ضخامة الأدب المنحرف الوثني. ومع ذلك، فإذا افترض أننا مضطرون إلى مدارسة هذا العصر، حينئذٍ لا مانع من التوفّر على دراسة النصوص المتضمِّنة لمبادئ ( التوحيد ) فحسب. أما سائر النصوص، فيكتفى منها بمجرد الإشارة، كأن نلفت انتباه الطالب إلى أن معظم نصوص الأدب الجاهلي تتضمن مبادئ منحرفة، لا حاجة إلى الوقوف عليها.
نعم، في حالة واحدة يمكننا أن نقدّم هذه النصوص، ولكن من أجل ( الردّ ) عليها، وتبيين مفاسدها، لا أن نقرّرها مادة مدروسة يحفظها الطالب، وإلاَّ نكون قد احتفظنا بكتب ( الضلال ) التي شدّد المشرع الإسلامي في المنع منها، وتوعّدنا بالعقاب على نشرها بين الناس.
إن مدرّسي الأدب الجاهلي، غافلون تماماً من أنهم يمارسون عملاً ( محرماً )، هو: نشر ( الضلال). تُرى هل انتبهنا على هذه الممارسة المحظورة شرعاً ؟! أرجو من الإسلاميين ( الملتزمين ) أن يتداركوا هذا الجانب، فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
* * *
وإذا اتجهنا إلى سائر عصور الأدب، وجدنا أن المشكلة ذاتها تتسرّب في دراسة مؤرّخي الأدب. فالمؤرّخون - تبعاً لإخضاع الدراسة للعصور السياسية - يتّجهون إلى الفترة التي تلي العصر الجاهلي و
متمثّلة في بزوغ الإسلام، ويقسّمونها إلى فترتين: فترة ( عصر القرآن )، ثمّ فترة ( الخلفاء ). بعدها يتّجهون إلى ( العصر الأموي)، ف- ( العصر العباسي )، ف- ( العصور المظلمة )، ف- ( العصر الحديث ). والملاحظ في مثل هذا التقسيم، أن دراسة الأدب تتم وفقاً لمعايير فنية، إلاَّ أنها مشدودة إلى عصر سياسي، وليس وفقاً لمعايير إسلامية في هذا العصر أو ذلك.
المؤرِّخ الإسلامي للأدب، ينبغي أن يتحفّظ أولاً في مشروعية التقسيم السياسي للعصور، مادام الإسلام ( سياسياً ) لم يكتسب سمته الحقة إلاَّ في فترات خاصة. وكلّنا يدرك محاولة كثير من المؤرّخين، إخضاع نمو الأدب لهذا العصر أو ذاك: تحقيقاً لهدف سياسي ( منحرف ). والقضية لا تخص - في الواقع - ظاهرة ( الأدب ) فحسب، بل تخصّ طبيعة التفسير التاريخي للظواهر بعامة، حيث ارتفع أكثر من صوت ( نظيف ) في عالمنا الإسلامي، مطالبا بضرورة إعادة النظر في تقويمنا للتاريخ الإسلامي، وغربلته من التفسيرات المنحرفة التي أصبحت وكأنها حقيقة تاريخية لا سبيل إلى التشكيك بها.
المهم، أن المؤرِّخ الإسلامي للأدب، بمقدوره أن يتناول دراسة الأدب وفقاً لمنظورة الإسلامي، سواء أكان ذلك في نطاق العصور التقليدية، أم في نطاق ما يصوغه بنفسه من تقسيم يأتلف مع الخط الإسلامي الصائب، أم في نطاق التقسيم الفني الخالص. في الحالات جميعاً، يظل المؤرِّخ الإسلامي للأدب، متّجهاً نحو ( انتخاب ) خاص لنصوص الأدب، بحيث يصبّ في رافد إسلامي لا غير. عليه ألاَّ يؤرّخ للشعراء غير الإسلاميين، سواء أكان النصّ غير الإسلامي ذا طابع ( فلسفي ) حيال الكون وتفسيره، أم ذا طابع ( انحرافي ) عن خط الإسلام، مثل: الجنس والخمر واللهو وسائر أنماط الفسق.
لقد اعتاد مؤرِّخو الأدب دراسة النص إما من حيث ( ترجمة ) صاحبه، أو من حيث ( فنون ) الشعر، من: خمريات وغزليات ومدائح ومراث وما إليها. هذا التقسيم التقليدي للفنون أصبح ( سمة ) دراسية بنحو كأنها ( قدر ) لا مفرّ لكل دارس وطالب من مواجهته.
إن الغزل والخمر والخمر ومدح الطغاة وما إليها من لأبواب التي انتظمت مناهج الدراسة، ينبغي إلاَّ يعنى بها الدارس الإسلامي، بل تظل محكومة بنفس الطابع الذي قلناه عن العصر الجاهلي. على الدارس الإسلامي، أن يصطفي ( منهجاً ) دراسياً خاصاً به، وهذا ما يمكن أن يتم وفق طرائق متنوعة، منها:
١ - انتقاء شاعر أو كاتب إسلامي ملتزم.
٢ - انتقاء نصّ إسلامي.
٣ - الاهتمام أساساً بنصوص ( الأدب التشريعي )، ونقصد به: نصوص القرآن الكريم، والأحاديث النبوية، ونهج البلاغة، وأحاديث أهل البيت، والأدعية... فمثل هذه النصوص، تشكّل
( أدباً تشريعياً ) مقابل ( الأدب الإسلامي الأرضي)، أي الأدب الذي ينتجه المسلمون الملتزمون.
إنه لمن المؤسف إلاَّ يتوفّر دارس إسلامي كبير، أو لا تتوفّر مجموعة أو مؤسسة تأخذ على عاتقها تنظيم المناهج الدراسية ل- ( الأدب التشريعي )، وتجعلها ( نموذجاً إسلامياً ) على نحو ما تشكل ( العقائد ) و( الفقه ) و( الأخلاق ): مباديء عامة للإسلام. فكما أن العقائد والفقه والأخلاق تجسّد ( أفكار ) قادة التشريع، كذلك فإن قصص القرآن وخطب النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم وأحاديثه، وخطب نهج البلاغة وأحاديث الإمام عليعليهالسلام وأحاديث أهل البيتعليهمالسلام ، ينبغي أن تجسّد أيضاً ( أفكار ) قادة التشريع.
أمَا كان الأجدر بعشرات الأساتذة الإسلاميين الذين يحتلون مراكز علمية مختلفة، أن يتّجهوا لتأليف كتاب مدرسي في تاريخ الأدب الإسلامي بدلاً من أن يصبحوا ( إمَّعات ) يتلقّون الأوامر من أعداء الإسلام، ويطوون أعمارهم في تدريس المواد غير الإسلامية، غافلين تماماً عن مسئوليتهم الضخمة في هذا الجانب ؟! إنه لمن المؤسف أن تجد عشرات الأساتذة الجامعيين ممّن يؤمن بالإسلام، و( يلتزم ) ببعض مبادئه ( من صلاة وصوم وحجّ وإنفاق مفروض... إلخ )، تجد متخصِّصاً في ( الأدب الجاهلي )، وتجد ثانياً في ( الأدب الأموي )، وثالثاً في ( الأدب العباسي )، ورابعاً في ( الأدب الأندلسي)، وخامساً في (الأدب القرون المظلمة )، وسادساً في ( الأدب الحديث ).
أقول: من المؤسف أن تجد هؤلاء الإسلاميين، يتقدّمون في دراساتهم بالحديث عن هذا الشاعر الجاهلي أو الأموي أو العباسي أو الأندلسي، ويفيضون في الحديث عن فنونه الشعرية، أو تطوّر الفنون والظواهر الأدبية، لكنّهم: بعيدون كلّ البُعد عن التعريف بالأدب الإسلامي الحق، وبظواهره وبمختلف شئونه. نعم، قد يعرضون لهذه الخطبة - مثلاً - أو لتلك القصة القرآنية بنحو عابر، في خضّم عرضهم لعشرات النصوص غير الإسلامية، بحيث لا تشكّل منهجاً له خطوطه الإسلامية، في حين تجد ( منهجية ) للأدب الأرضي المنحرف، يتوفّر عليها كلّ الأساتذة الجامعين..(١) .
أعرف - على سبيل المثال - أستاذاً جامعياً عُهد إليه تدريس الأدب الجاهلي، كما عهد إليه تدريس أكثر من عصر أدبي قديم وحديث، وقد استثمر الأستاذ المذكور حرية اختيار المادة ( وهي حرية يتّسم بها الأساتذة الجامعيون بخلاف مدرّسي التعليم الثانوي )، فكانت محاضراته تصب في رافد إسلامي وإنساني عام، فدرّس القرآن وخطب النهج، وبعض النصوص ذات الطابع التوحيدي والإنساني العام (فيما يتّصل بالأدب الجاهلي)، والامر ذاته فيما يتصل بسائر عصور الأدب، ونجح في مهمته المتقدمة. نعم، كان بعض المتوجسين خيفة، يشفق عليه من المسئولين، وينصحه بعدم مخالفة المنهج المتّبع تقليدياً... إلاَّ أن الأستاذ المذكور، تابع مهمته العبادية دون أن تواجهه أية شدّة
____________________
(١) انظر كتابنا: "تاريخ الأدب في ضوء المنهج الإسلامي ".
يتوقعها الآخرون، بخاصة أنه كان يتصرّف بمهارة فائقة في تمرير خطته الإسلامية في التدريس.
إن الأساتذة الإسلاميين لو أتيح لهم جميعاً بممارسة مثل هذا التصرف في مناهج الدراسة، لأحدثوا - دون شك - انقلاباً ثقافياً يفرضه انتماؤهم الإسلامي. علماً بأن ( المسئولين المنحرفين ) لا يمتلكون جرأة كاملة على معارضتهم في تدريس النصوص الإسلامية، ماداموا متمسّكين بالمظهر الشكلي للإسلام، ويعدونه: الدين الرسمي لأنظمتهم.
على أية حال، من المتعيّن على المهتمين بشئون الأدب وتدريس تأريخه، أن يبدءوا من الآن بممارسة وظيفتهم العبادية ولو في نطاق صغير من إمكاناتهم، بخاصة أن ( الوعي الإسلامي ) في سنواتنا المعاصرة بدأ يقتحم أسوار الأرض بعد قيام أول حكومة إسلامية معاصرة، لا تزال تواصل رحلتها الشاقة في إحداث ثورة ثقافية في جام-عاتها.
إن الجهود الفردية أو الاجتماعية ( في النطاق الأهلي ) بمقدورها أن تضطلع بمهمة التاريخ الإسلامي للأدب، ودراسته وفق التصوّر الخاص به. بمقدورها أن تبدأ ذلك بممارسته في مؤسسات أهلية، كما يمكنها أن تتوفّر على ( التأليف ) فحسب، تاركة عملية ( التدريس ) وتطبيق المنهج الإسلامي، لظروف التي تسمح بذلك.
أما خطوط هذا المنهج، فليس من الصعب أن يُتوفَّر عليها، مادمنا نملك تراثاً تشريعياً و( إسلامياً عاماً ) متنوّعاً طيلة تأريخنا الإسلامي.
الأدب التشريعي
بالرغم من أن نصوص الكتاب والسّنة - بصفتها ( دستوراً ) كُتبَ بلغةٍ مباشرة - تتعامل مع الحقائق وفق أداءٍ ( علمي)، دون أن تتوكّأ على عناصر ( التخيّل ) و( الإيقاع ) ونحوهما من أدوات التعبير ( الفنّي ).. بالرغم من ذلك، فإن النصوص الشرعية لم تقتصر في لغتها على الأداء ( العلمي ) وحده، بل نلحظ أنّ غالبيّتها قد روعيَ فيها ( الأداء الجمالي ) أيضاً. والسّر في ذلك لا يعود إلى مجرّد توافق هذا النمط من العناية بجمالية النصوص مع البيئة الأدبية التي ألِفَتْها الحياة عصرئذٍ فحسب، بل يعود أيضاً - وهذا ما يميّز اللغة الشرعية - إلى ملاحظة الأهمية التي يفرزها ( الفن ) في ميدان الاستجابة البشرية لمختلف الظواهر: من حيث تعميقه وبلورته للدلالة التي يستهدفها النص الشرعي.
إن للفن علاقته ب- ( البُعد العاطفي ) الذي يمكن استثماره في تمرير الحقائق التي يحرص الشرعُ على توصيلها إلى الأذهان، حيث يشكّل كلٌ من البعد ( العاطفي ) و( العقلي ) وجهين لعملية ( الإدراك )، كلّ ما في الأمر أن استخدام ( البُعد العاطفي ) وفق نِسَب محدَّدة، يظل مرتبطاً بمدى قدرات الكُتّاب ( الأرضيين ) وعدمها على تحقيق ذلك. وهذا على العكس من النصوص ( الشرعية ) التي تمتلك ناصية اللغة وأدواتها ودلالاتها تبعاً لمعرفتها بالتركيبة الآدمية وطرائق استجاباتها، ومن ثَم تستخدم ( البُعد العاطفي ) بنسبة معيّنة لا تتجاوزها، محقّقة بذلك تآزرَ كلٍ من ( البُعد العقلي والعاطفي ) في مُجمل استجابة الإنسان للظواهر، بحيث لا تقف بالقارئ والسامع عند عتبة ( المنطق ) وجفافه، ولا بجموح ( الانفعال ) ومفارقاته، بل توشّح كل ما هو ( عقلي ) بنثارٍ من ( العاطفة ) الرصينة، وهو ما يطبع التعبير - أيَّاً كان - بسمة ( الفن ).
إن هدفنا من هذه الدراسة السريعة هو: إبراز القيم الفنّية في نصوص ( الشرع )، ومحاولة رصدها - ولو عابراً - في مختلف أشكال التعبير، مع ملاحظة أن النصوص الشرعية تبقى منحصرة في ( النثر ) بطبيعة الحال، مادام ( الشعر ) لا وجود له في القرآن، ومادام النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم وأهل البيت ( ع ) لم يتوفّروا على كتابة الشعر. وأما ما ينسبه المؤرّخون من الشعر
إلى ( الأئمةعليهمالسلام ، ففي تصوّرنا أنّه ( منسوبٌ ) إليهم فعلاً، وإِن لم نستبعد أن تكون بعض الأبيات أو المقطوعات أو القصائد قد صدرت عنهم بالفعل، إلاَّ أن مقارنةَ ما نُسِبَ إِليهم من ( شعر )، بما قدّموه من خطب ورسائلَ وأدعية وأحاديث، تجعلنا على يقين أو شبه يقين بأنّ ( الشعر ) المنسوب إِليهم لا واقعَ له، بقدر ما نتوقّع أن يكون استشهادهم وتلاوتَهم لنتاج الآخرين، هو الذي أوهم بعض المؤرّخين بأنّ ذلك من نتاجهمعليهمالسلام .
كانواعليهمالسلام طالما يستهدون بنصوص شعرية لتقرير حقيقة من الحقائق يستدعيها السياق، وهي مواقف مختلفة من الممكن الرجوع إليها في مظانّها. والمهم أن مقارنة النصوص النثرية في ( نهج البلاغة ) مثلاً، بالديوان المنسوب للإمام عليّعليهالسلام ، هذه المقارنة تظهر لنا مدى الفارق الكبير بين النثر الفني الذي اشغل النقاد قديماً وحديثاً وبين ( الشعر ) المنسوب إليه ( من حيث عدم توفّر عناصر الفن المعجز )، بل حتى ( العادي ) منه. وقد انتبه أكثر من مؤرّخ أدبي إلى خطأ ( النسبة ) المذكورة في بعض قصائد ( الديوان ) وأرجعها إلى أصحابها الحقيقيين.
وحتى مع افتراض أن بعض الأبيات أو المقطوعات ثابتة الانتساب إِليهم ( ع ) - وهذا ما لم نستبعده كما قلنا، ومنه الأراجيز مثلاً - فإن محاولة تسجيلها دراسياً لا ضرورة له، مادامت لا تشكّل ( طابعاً عاماً ) لكتاباتهم ( ع )، بقدر ما هي مجرد تسجيلٍ لموقف خاص أملته حربٌ أو حادثة أو مقابلة، كانوا يستهدفون من خلالها إِظهار حقيقة من الحقائق دون أن تجسّد سمةً عامةً لنتاجهم كما قلنا.
وأيّاً كان، فإن ( النثر ) يظل هو النتاج الذي نحاول دراسته في ( الأدب الشرعي )، منحصراً - كما هو واضح - في زمن النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم وأئمة أهل البيت ( ع ).
هذا إلى أننا سوف لن نُعنى بتسليط الأضواء التاريخية على النص بالنحو الذي اعتاد مؤرِّخو الأدب عليه ؛ مادمنا في صدد دراسة ( الفن ) وليس في صدد دراسة ( التأريخ )، إلاَّ في حدود الإنارة التاريخية لبعض النصوص التي تتطلب دلالتُها وقيمُها الفنية مثلَ هذه الإنارة. وخارجاً عن ذلك، فإن دراستنا السريعة ستنصبّ على التحليل والتفسير والتقويم والتعريف بخصائص النص جمالياً، مضافاً إلى التعريف بقيمه ( الفكرية ) أيضاً، مادامت القيمُ الفكرية هي ( الهدف ) أساساً، ومادام ( الفنُ ) موظّفاً من أجل القيم الفكرية المذكورة.
أخيراً، سوف لن نُعنى أيضاً ( في تقويمنا للنصوص ) بالمعايير البلاغية الموروثة إلاَّ في نطاق نادر، بقدر ما نلتزم بالمعايير التي تبلور قيمة النص، بغض النظر عن كون المعيار موروثاً أو حديثاً.
ونظراً لتميّز ( القرآن الكريم ) بخصائص متفردة، لا يماثلها أي نص بشريّ، حينئذٍ سنفرد له فصلاً خاصاً، على أن ينتظمَ النصوصَ المأثورةَ عن أهل البيتعليهمالسلام فصلٌ آخر.
ونبدأ أولاً ب-:
النصّ القرآني
يُعّد النص القرآني الكريم ضرباً من التعبير المعجز، سواء أكان ذلك من حيث الشكل الخارجي للنص، أو لغته التعبيرية، أو مضمونه. فمن حيث الشكل الفني يتفرَّد القرآن بهيكلٍ خاص له تميّزه عن أشكال الأدب المعروفة: من قصة ومسرحية ومقالة وخطبة وخاطرة ورسالة وحكاية وقصيدة إلخ... إلاَّ انه في الآن ذاته تنتظمه عناصر مختلفة من الأشكال المتقدمة بحيث يسمه بالطابع المتفرد: كما هو واضح. ومن حيث اللغة التعبيرية، فإن عناصر ( الصورة ) و( الإيقاع ) و( البناء العماري ) وسواها، تظل طابعاً ملحوظاً في النص القرآني على نحو يسمه بالتفرّد الذي أشرنا إليه، أيضاً.
وأما من حيث ( المضمون )، فإن ( الرسالة الإسلامية ) بمختلف جوانبها تظل - كما هو بيّن - البطانة الفكرية للنص، وهو أمر لا يحتاج إلى التعقيب عليه من حيث ( تفردّه ) في ذلك.
ونظراً لتنوّع السمات الجمالية في النص القرآني، فإن محاولتنا الدراسية تحرص على تناول الجوانب التالية منها:
١ - السورة ( من حيث البناء العماري لها ) اي: السورة من حيث كونها ( هيكلاً ) هندسياً يتم وفق خطوطٍ تتواشج وتتنامى عضوياً بنحو تصبح - من خلاله - كلُّ آيةٍ أو مقطعٍ أو قصة، ذات صلة بما تقدّمها وبما لحقها، كأن تكون سبباً أو مسبّباً لها، أو تكون تمهيداً لتفصيل , أو تطويراً لموقف أو حادثة... إلخ.
٢ - العنصر القصصي: نظراً لأهمية هذا العنصر في الاستجابة الفنية للنص، ولتوفّره بشكلٍ ملحوظ فيه، ولغنى أشكاله التي يستخدمها: بناءاً أو رسماً للشخوص والبيئات والحوادث، أو طرقاً للحوار والسرد و... إلخ، نظراً لهذا كله، يظل التناول للعنصر المذكور من الأهمية بمكان.
٣ - العنصر الصوري: ونقصد به التعبير غير المباشر عن الحقائق، بخاصة التركيب القائم على رصد العلاقة بين ظاهرتين، واستخلاص دلالة جديدة منهما فيما يُصطلح عليه ب- ( الصورة) ،
وهي تحتل موقعاً له أَهميتهُ في نصوص القرآن.
٤ - العنصر الإيقاعي: وهو مجموعة الأصوات (المنتظمة) في شكل (قرار) تنتهي عنده الآية، أو (تجانسٍ) بين مختلف الأصوات التي تنتظم التعبير(١) .
وهناك بطبيعة الحال جوانب فنّية أخرى توفّر عليها مختلف الدارسين، قديماً وحديثاً، بخاصة فيما يتصل باستخدام (المفردات) و(التراكيب)، إِلاَّ أننا آثرنا عدم معالجتها لِجملةٍ من الأسباب، منها إمكانية خضوعها ل- (الدراسات اللغوية) أكثر منها ل- (الدراسات الجمالية)، التي تُعنى بتوضيح طرائق (الاستجابة المؤثرة)، وهي طرائق لا (يعيها) القارئ بقدر ما (يتحسّسها)، دون أن يدرك السّر الكامن وراء ذلك.
على أية حال، المطلوب من المعنيين بدراسة (اللغة) وطرائق صياغتها الفنية، أن يتوفّروا على المزيد من البحث في هذا الجانب، الذي ينطوي على أسرار ممتعة تتسم ببالغ (الدقّة) في اختيار (المفردة) واستخدامها في موقف أو موضوع، واستخدام أخرى (مرادفة) لها في موقف أو موضوع آخر، وهكذا.
على أية حال، نبدأ الآن بدراسة العنصر المتصل ب-:
١ - الهيكل العماري للسورة:
من الحقائق المألوفة (في تاريخ القرآن) أن ترتيب آياته تمّتْ بتوجيه من النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم ، مما يعني عدم وقوع أي تغيير في (مواقع) الآيات التي تنتظم السورة. وعندما تنتظم الآيات وفق ترتيب خاص (بحيث كان النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم يأمر بوضع هذه الآية في الموقع الفلاني مثلاً) حينئذٍ يعني أن (السورة) خاضعة لبُعدٍ هندسي يأخذ كلّ موقعٍ منه وظيفته بالنسبة إلى مجموع السورة.
وإِذا أدركنا هذه الحقيقة التاريخية ،... عندها يتعيّن على الدارس الأدبي أن يُعنى بعمارة السورة بنحوٍ يتناسب وخطورة هذه الظاهرة البنائية، مادام مبنى السورة بشكلٍ عام له إِسهامه الكبير في إِحداث الإثارة المطلوبة في النفوس(٢) . فالقارئ قد لا (يعي) بعد انتهائه من تلاوة السورة، مدى ما تركته من تأثير في أعماقه: بسببٍ من جهله بطرائق الصياغة الفنية التي تأخذ عمليات الإدراك بنظر الاعتبار، إِلاَّ إذا كان على إحاطة بالعمليات النفسية والطريقة التي (تؤثّر) على توصيل الأفكار المطلوبة. إن الأعمال الأدبية الحديثة، من رواية ومسرحية وقصيدة، انتهت - بعد قطعها عشرات الأجيال من عمليات التطوير الفني - إلى تقنية النص الأدبي وفق مبنيً هندسي: يتناول موضوعات مختلفةً لا علاقة لبعضها بالآخر، ثم إِخضاع هذه الموضوعات المتباينة إلى (فكر) أو
(شعور) يوحّد بينها، ويمثّل قاسماً مشتركاً بين تلكم الموضوعات. وقد ساهمت مكتشفات علم النفس الحديث (بخاصة: المدرسة التحليلية، والجشطالتية) في دفع هذا الاتجاه الأدبي إلى الأمام، مفيداً من عمليات (التداعي الذهني) و(الإدراك الجشطالتي)، أي: إدراك الشيء من خلال (كليّات)، ونحوهما من العمليات النفسية الأخرى في صياغة العمل الأدبي، عبْر تناوله لموضوعات لا رابطة بينها، وإخضاعها لعملية (فكرية) توحّد بينها.
إن ما يعنينا من هذا التلميح العابر إلى التقنية الأدبية المعاصرة، لفت الانتباه إلى الأهمية الفنية لسور القرآن الكريم من حيث تنوّع موضوعات كل سورة، وتلاحم هذه الموضوعات فيما بينها: من خلال خيط (فكري) يجمع بينها، وهو أمر لا يكاد القارئ العابر ينتبه إليه.
والحق، إن السورة القرآنية الكريمة تتّجه إلى أكثر من صياغة في (وصل) الموضوعات المتنوعة التي تطرحها. فقد (تتنامى) الموضوعات عضوياً، أي يشكّل أحدُها تطويراً لفكرةٍ تأخذ تفصيلاتها لاحقاً، أو تأخذ شكل (تفريعات) على موضوع رئيس، أو تأخذ شكل (تجانس) بين الموضوعات، أو يجمع بينها (هدف) يتسّلل إلى جميع الموضوعات... وهكذا.
إن سورة (البقرة) التي تعد أكبر سور القرآن حجماً، نجدها مثلاً قد توزَّعتها عشرات الموضوعات التي لا علاقة لبعضها بالآخر، ففيها موضوعات تتصل بالأحكام الشرعية من صلاة، صوم، حج، زكاة، قصاص، ربا، جهاد، نكاح، طلاق... إلخ، وفيها موضوعات تتصل بالإبداع الكوني والإبداع البشري، فضلاً عن الموضوعات التاريخية المتصلة برسالة الإسلام، وبرسالات الأنبياء السابقين وموقف الجمهور منهم، إلى غيرها من الموضوعات المنتثرة في السورة. كل أولئك لم تُصغ في مواقعها من السورة إِلاَّ وفق عمارة تخضع خطوطها المتباينة لتخطيط هندسي بالغ الإثارة من حيث إِحكامه.
طبيعي لا يمكننا أن نتحدث الآن عن التلاحم العضوي بين موضوعات السورة ؛ لأن ذلك يستغرق كتاباً مستقلاً بنفسه، لكننا نستطيع أن نشير عابراً إلى أنّ السورة بدأت بمفهومات تتصل بالإيمان بالغيب وبالرسل، وانتهت بطرح المفهومات ذاتها، بعد أن قطعت رحلة طويلة تتصل بمجمل المفهومات المتقدمة، منتقلةً من موضوع لآخر: من خلال (تمهيدٍ) له، أو (تجانس) بينهما، أو تفريعٍ عليه. وحتى العناصر الثانوية في السورة (وُظّفت) لإنارة ما هو (رئيس) فيها.
فمثلاً نجد أن قصة (البقرة) التي تضمّنت حادثة (الإماتة والإحياء)، وكانت واحدة من عشرات المواقف التي تحدّثت عن الإسرائيليين، قد وجدت خطوطاً تجانسها في أكثر من موقع من السورة، مثل: قصة الذي( مَرّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ) ، حيث( قَالَ أَنّى يُحْيِيْ هذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِاْئَةَ عَامٍ ثُمّ بَعَثَهُ ) . ومثل قصة إبراهيم (ع) مع الطيور الأربعة التي قُطّعت ثم أُحييت. ومثل قصة( الّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُوْا ثُمّ أَحْيَاهُمْ ) ،
ومثل مناقشة إبراهيم مع نمرود في قضية الإحياء والإماتة.
إذن كل هذه الحوادث والمواقف حامت على نفس فكرة (الإحياء والإماتة) التي تضمنتها قصة (البقرة)، في تشكيلها عصباً لثلث السورة التي تحدثت عن الإسرائيليين ومواقفهم المشينة طوال التأريخ، ثم وصلها بحادثة (البقرة) التي عقبت القصةُ عليها بأن الله قدّم هذه الظواهر الإعجازية( لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ ) .
إن هذا التوزيع الهندسي لأحد مواقع السورة المتصل بظاهرة الإحياء والإماتة، يظل جزءاً من توزيع هندسي عام لكل موضوعات السورة التي لا تسع هذه الصفحات القليلة لتبيينها، فيما استهدفنا من ذلك مجرد لفت الانتباه إلى عمارة السورة القرآنية وإِحكامها العضوي في هذا الصدد. ويمكننا أن نقدّم نموذجين آخرين، أحدهما: متوسط الحجم، والآخر صغير الحجم من سور القرآن الكريم ؛ حتى يتضح للقارئ المبنى الجمالي لمجمل السور: كبيرها ومتوسطها وصغيرها.
سورة الكهف مثلاً تجسّم حجماً متوسطاً من سور القرآن، وتتناول موضوعات مختلفة، إِلاَّ أن هناك (خيطاً فكرياً) يوحّد بين كل الموضوعات المختلفة، ألا وهو (نبذ زينة الحياة الدنيا). وقد جاء هذا (الهدف الفكري) في أوائل السورة التي قالت:( إِنّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ (زِينَةً) لّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً * وَإِنّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً ) .
هذه الفكرة المتصلة بزينة الحياة الدنيا وإلى أنها تتحوّل إلى أرض جرداء في النهاية، وإلى أن (امتحان) الكائن البشري هو الهدف من مواجهته للزينة المذكورة.. هذه الأفكار هي (البطانة) التي تحوم عليها كل موضوعات السورة، فنحن حين نمعن في ملاحظة موضوعات السورة، نجدها قد بدأت أولاً بحادثة أهل الكهف، التي تمثّل سلوكاً عمليّاً لنبذ زينة الحياة الدنيا، حيث توجّهت جماعة مؤمنة إلى الكهف للتخلّص من مسئولية التعاون مع الحكّام الظالمين. ولا شيء أدل على نبذ الحياة من اللجوء إلى الكهف الذي يمثّل نبذاً كاملاً لزينة الحياة الدنيا: كما هو واضح. هذا مع ملاحظة أن السورة قدمت في هذه الحادثة نموذجاً إيجابياً من التعامل مع زينة الحياة الدنيا.
ثم جاء الموضوع الثالث من السورة (كان الموضوع الأول هو: التمهيد بالآيتين اللتين تحدثتا عن الزينة والجزر والبلاء، وكان أهل الكهف: الموضوع الآخر). جاء الموضوع الثالث متصلاً بالحديث مع النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم والجمهور واليوم الآخر، وجاءت المطالبةُ التالية من خلال ذلك:( وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدّنْيَا... ) .
إذن: الموضوع الثالث جاء متحدثاً عن الزينة أيضاً، ولكن في موضوعٍ لا علاقة له بأهل الكهف.
الموضوع الرابع من السورة هو: موضوع الرجلين اللذين جعل الله لأحدهما جنتين من أعناب( وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزّ نَفَراً ) ، وقال أيضاً:( وَمَا أَظُنّ السّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رّدِدتّ إلى رَبّي لَأَجِدَنّ خَيْراً مِنْهَا مُنقَلَباً ) ، وقال عن مزرعته:( مَا أَظُنّ أَن تَبِيدَ هذِهِ أَبَداً ) . ولكن ماذا حدث بعد ذلك ؟( وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلّبُ كَفّيْهِ عَلَى ما أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ) .
إذن: هذه الحادثة جاءت موضوعاً رابعاً عن التعامل مع زينة الحياة الدنيا. وهي من حيث الموقع الهندسي تمثّل طرفاً سلبياً للتعامل مع زينة الحياة الدنيا، مقابل أهل الكهف فيما يمثّلون طرفاً إيجابياً مع الزينة المذكورة. مضافاً إلى ذلك جاءت إبادة مزرعته متوافقة هندسياً مع مقدمة السورة التي قالت:( وَإِنّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً ) . وها هي مزرعة الرجل تصبح (صعيداً جرزاً)، حيث أصبحت( خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ) .
لنلاحظ هذا المبنى العماري المتصل بعلاقة مقدمة السورة بهذه الحادثة، وعلاقة هذه الحادثة مقابلة بحادثة أهل الكهف الإيجابيين، وتمثّلهم خطاً هندسياً مقابلاً لخط صاحب الجنتين. ولنتابعْ...:
وجاء موضوع جديد في السورة وهو الموضوع الخاص، يعرّفنا بالحياة الدنيا على هذا النحو:( الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبّكَ... ) .. إذن: الموضوع الخامس جاء متحدثاً عن الزينة مع تذييله بموضوعات تتصل بالنمط الكافر من الآدميين وتعاملهم مع الشيطان ؛ تناسقاً مع الخط الذي رسمته السورة لصاحب الجنتين.
ثم جاء الموضوع السادس من السورة متحدِّثاً عن قصة (موسى) مع (العالم) في مواجهته لخرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار. طبيعي قد يبدو للقارئ العابر أن هذه الحادثة أجنبية عن موضوع (الزينة) وطرائق التعامل حيال ذلك، ولكنه لو تأمّل بدقة، لَلحظَ أن (العالِم) الذي انبهر موسى أمام شخصيته التي لا يعرفها حتى (موسى (ع) )، إنما تمثّل (انعزالاً) كاملاً عن الدنيا، بحيث لا يعرف هذه الشخصية حتى (الأنبياء)، إنها شخصية منعزلة مختفية حتى عن الأنظار الخاصة (لا نغفل التجانس بين (الكهف) و(الاختفاء) لدى كلٍ من أصحاب الكهف والعالِم).
الموضوع السابع في السورة هو: قصة ذي القرنين. وأدنى تأمّل لهذه الشخصية وسلوكها، يُداعي بأذهاننا سريعاً إلى جملة من الخطوط الهندسية التي تتوازى وتتقابل بشكل مُذهلٍ وجميل بين حوادث وشخصيات السورة. فذو القرنين لو قابلناهُ بصاحب الجنتين للحظنا الفارق الكبير بينهما من حيث (تملّك) كلٍ منهما لأحد مظاهر الحياة، ومن حيث (موقفهما) من ذلك. فصاحب الجنتين لا يملك إِلاَّ جنتين فحسب من مساحة الله الواسعة: لكنه مع ذلك. فصاحب الجنتين لا يملك إلاَّ جنتين فحسب من مساحة الله الواسعة: لكنه مع ذلك بهرته (زينة) الحياة الدنيا. بينا نجد أن ذا القرنين تملّك شرق الدنيا وغربها: لكنه
لم تبهره الحياة الدنيا، بل ظلّ على تعامله الإيجابي مع الله. وذو القرنين يتعامل إيجابياً مع الله (وهو معروف لدى كل الجمهور)، يوازنه (العالِم) الذي يتعامل إيجابياً أيضاً (وهو لا يعرفه حتى موسى). وذو القرنين يمثّل خطاً من الحياة هو (البروز) أمام الدنيا كلها، بينا يمثّل أهل الكهف خطاً هو (التخفّي) عنها في مكانٍ منغلق...
إذن، كل هذه الخطوط، المتوازنة حيناً والمتقابلة حيناً آخر تتناسق فيما بينها هندسياً لتصبّ في رافدٍ واحدٍ، هو: التعامل مع الحياة الدنيا: إيجاباً أو سلباً من خلال (الزينة) وطرائق الاستجابة لها.
الموضوع الثامن والأخير من السورة، هو الحديث عن الأخسرِين( الّذِينَ ضَلّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً ) ، مرتبطاً ببداية السورة التي تحدثت عن هؤلاء الذين طالبت النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم ألاَّ يهلك عليهم نفسه، وإلى أن (زينة) الحياة الدنيا جُعلت (امتحاناً) لهم ولمطلق الآدميين. هذا ولا نغفل صلة هذا الموضوع بصاحب الجنتين الذي حسب أنه يحسِن صنعاً في قوله( وَلَئِن رّدِدتّ إلى رَبّي لَأَجِدَنّ خَيْراً مِنْهَا مُنقَلَباً ) .
إذن: جميع موضوعات السورة حامت على (هدف محدد)، هو: التعامل مع (زينة) الحياة الدنيا وموقع (الامتحان) من ذلك: بما يواكبه من عمليات الثواب والعقاب أخروياً ودنيوياً، على النحو الذي أوضحناه سريعاً.
وإليك النموذج الثالث من عمارة السورة القرآنية في السور القصيرة. وهي سورة (المطفِّفين):
لقد بدأت سورة المطفِّفين بهذا الحديث:
( وَيْلٌ لِلْمُطَفّفِينَ * الّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلاّ يَظُنّ أُولئِكَ أَنّهُم مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النّاسُ لِرَبّ الْعَالَمِينَ ) .. ثم انتقلت السورة إلى موضوعٍ آخر يتصل بالمكذّبين باليوم الآخر، وإلى أنه، ران على قلوبهم ما يكسبون... وأردفت ذلك بالحديث عن الجنة والجحيم: بصفتهما ترغيباً وترهيباً لعملية تعديل السلوك. وانتهت إلى رسم يقابل بين المؤمنين والمكذبين في كلٍ من الدنيا والآخرة: حيث كان المكذِّبون يضحكون من المؤمنين في الحياة الدنيا، وهاهم الآن (في اليوم الآخر) يضحك المؤمنون من المكذّبين.
موضوعات السورة هي: المطفِّفون، ثم: المكذبون، الحساب في اليوم الآخر، التقابل بين الفريقين. طبيعياً، ان التكذيب ونتائجه في اليوم الآخر، وإبرازه متقابلاً مع الإيمان ونتائجه، ثم: الضحك المتقابل بين الفريقين: كلّ ذلك يتمّ هندسياً وفق تسلسل موضوعي. ولكن قضية (المطفِّفين) تبقى وكأنها (أجنبية) تماماً عن موضوع التكذيب ونتائجه.
إننا يمكن أن نقرّر بكل سهولة أن السورة حينما تُستهل بموضوع ما، فإن نفس هذا الاستهلال يكشف عن أهمية (الموضوع). وحينما تطرح بعد ذلك موضوعاً آخر له أهميته
القصوى، وهو: التكذيب باليوم الآخر ونتائجه، حينئذٍ يستكشف القارئ بسهولة أن هناك علاقة بين خطورة التكذيب وخطورة التطفيف. ومع أن أحدهما غير الآخر، إِلاَّ أنهما يخضعان لخطورة متجانسة من حيث المفارقة التي ينطويان عليها، ومن حيث النتائج المترتبة على ذلك، بخاصة أن الحديث عن المطفِّفين قد ختمته السورة بالإنذار القائل:( أَلاّ يَظُنّ أُولئِكَ أَنّهُم مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ) ، فهذا اليوم العظيم الذي حذّرت منه السورةُ هؤلاء المطفِّفين، قد رسمته بعد ذلك لمطلق المكذّبين: بحيث (يتداعى) الذهن مباشرةً إلى الربط بين (يوم الدين) الذي هدّدت به السورة، وبين (يوم الدين) الذي فصّلت الحديث عنه بالنسبة إلى المكذبين.
إذن: كلّ ما حدّثنا النصُ به عن المكذّبين، (تتداعى) أذهانُنا من خلاله إلى (المطفِّفين) أيضاً، بحيث يستجيب القارئ إلى القضيتين بطريقة (موحَّدة)، تدعه - ولو بشكل غير واعٍ - قد اتجه بعد تلاوة السورة إلى إدراك أن التكذيب بيوم الدين مفارقة ضخة تترتب عليها نتائج من أبرزها: ضحك المؤمنين( هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلاَلٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتّكِئُونَ ) من المكذبين (وهم في جهنم)، وإلى أن (المطفِّفين) أيضاً من الممكن أن يواجههم المصير ذاته. وتظل النتيجة هي: أن (المطفّف) (وهو في حالة كونه مؤمناً بالله) سيحاول تعديل سلوكه: وهو (هَدَفُ) النص فكرياً، وإلاَّ فإن المكذبين أساساً يظلون بمنأى عن تلاوة القرآن الكريم والإفادات منه في تعديل السلوك.
على أية حال، إِنّ سائر السور القرآنية تظل مطبوعة بنفس هذه السمة التي لحظناها في سورة المطفِّفين، أو (التجانس) الملحوظ بين موضوعات سورة الكهف، أو (التلاحم) بين موضوعات سورة البقرة، وهي جميعاً تخضع لأسرار العمليات النفسية التي لا يدركها القارئ العابر، بقدر ما (يتأثر) بها بشكل لا واعٍ، بحيث (يتحسّس) وهو ينتهي من تلاوة هذه السورة أو تلك: أن (انطباعاً) محدداً قد تركزّ في ذهنه، يتميز عن (الانطباع) الذي تتركه سورة أخرى... وهذا ما يستهدفه الفن العظيم من خلال رسمه لكل سورة (هدفاً خاصاً) بها.
٢ - العنصر القصصي:
القصة (ومثلها: المسرحيّة) - كما أشرنا - شكل أدبيّ يمتد بجذوره إلى العصر الإغريقي. وقد مرّ بمراحل من التطور: بخاصة منذ القرن الماضي، حتى انتهى إلى النحو الذي نألفه في حياتنا المعاصرة من نضجٍ وتنوّعٍ في أشكاله وتقنيته.
أمّا في آداب اللغة العربية، فلم يُعرف هذا الشكل الفنّي في العصور الموروثة، خلا بعض النماذج العادية التي لم تتوفّر فيها عناصر (القص المألوف)، فيما لم تسحب أدنى أثر على الحياة الأدبية بالقياس إلى ما ألِفَه الأدب الموروث من أشكال فنّية متنوعة احتفظت بفاعليتها حتى
العصر الحديث، وفي مقدمة ذلك: الشعر العمودي.
أما في آداب اللغة العربية الحديثة، فقد كان هذا الشكل - مثل سائر ضروب الفن - متأثراً بالتيار الأوربي الذي أخذ طريقه إلى الأذهان منذ أخريات القرن الماضي، ممّتداً بفاعليته إلى سنواتنا المعاصرة على نحو ما نعرفه جميعاً في هذا الصدد.
والمُلاحَظ أنّه في غمرة الغياب الكامل لهذا الفن في العصور القديمة، إذا بالقرآن الكريم يطل على اللغة العربية بعنصر (القصة)، ليس في مجرّد توفّر عناصر القص الفنّي فيها فحسب، بل في توفّر أشكال الصياغة التي لم تخبرها إِلاَّ التقنية القصصية الحديثة. طبيعياً، لا قيمة البتة لأيِّ فنٍ (أرضي)، حديثاً كان أم قديماً، بالقياس إلى (مبدع) الكائن الآدمي الذي علّمه الله ما لم يعلم. بَيْد أننا أردنا من هذه الإشارة للفنّ القصصي لفْت الانتباه إلى خلوّ الساحة الأدبية من الفن المذكور في عصر الرسالة الإسلامية، وعدم استثمار أهميته العظيمة عند المعنيّين بشئون الأدب عصرئذٍ، بخاصة في توفّره على نمطٍ من القصة (العمليّة) التي لم تجد لها طريقاً إلى الظهور، مع توفّر عناصر الفن، لا في آداب اللغة الأجنبية ولا في آداب لغتنا.
إن (القصة العمليّة) التي تطبع سمة القرآن الكريم، تجسّد نمطاً من الطرح الحقيقي ل- (الواقع)، لا أنّه مجرد (محاكاة) أو (كشف) أو (رؤية) للواقع الذي تخضعه القصةُ الأرضيّة لظاهرة (الإمكان) أو (الاحتمال). بكلمة أخرى: القصة القرآنية الكريمة لم تكن مجرّد (اصطناع) للواقع - كما هو طابع القصة الأرضيّة - بل هو تناولٌ لنفس (الواقع)، ولكن وفق عملية (اصطفاء) لحوادثه وشخصياته وبيئاته، بحيث يتميّز حتى عن بعض أشكال القصة التي عرفتها (الأرضُ) في نمطها المسمّى ب- (القصة التاريخية)، فيما تتناول (هذه الأخيرة) شرائح معيّنة من حوادث (الواقع) أيضاً، ولكن (تضيف) إِليه عناصر (مصطنعة) يستهدفها القاص لأغراض فنّية تتصل ب- (التشويق) وغيره، ولأغراض فكرية تجسّد إبراز (وجهة النظر) للقاص، وهذا ما يسلخ عنها سمة (الواقع العملي) أيضاً، إلاّ تلك النماذج التي تخلو من عناصر الفن، مما ينأى عن طابع العمل الفنّي.
وأيّاً كان الأمر، فإن (القصة العملية) تختلف - كما هو واضح - عن (القصة الواقعية) و(القصة التاريخية) اللتين ألِفتْهُما (الأرض)، من حيث كون أُولاهما (كشفاً) للواقع، ومن حيث كون أُخراهما (تحويراً) للواقع، في حين أن (القصة العملية) (نقلة فنّية) للواقع.
يترتّب على ذلك أن عمارة القصة القرآنية ستأخذ خطوطاً خاصة تتناسب مع طابعها (العملي) المذكور بنظر الاعتبار، ومن ثَمّ فإن المعايير التي ينبغي مراعاتها في دراسة القصة القرآنية لا تتحدّد، ضرورةً، بمبادئ النقد الجمالي الذي عرفته (الأرض) بقدر ما ينبغي أن
تتفرّد بمبادئ جمالية خاصة من جانب، وتأخذ - في الآن ذاته - مُجمل المبادئ التي تحكم الاستجابة البشرية في تلقّيها للنص الأدبي من جانب آخر، أي: أنها تجمع بين معايير نخبرها، نحن القرّاء، وبين معايير غائبة عن قدراتنا المحدودة. هذا، إلى أنّه يتعيّن علينا، عند التعريف بالقصة القرآنية، أن نشير إلى موقع القصة من السورة القرآنية الكريمة، مادام العنصر القصصي (موظّفاً) لإنارة مضمونات النص القرآني، وليس مجرّد شكل فنّي يستقل بذاته.
وبالرغم من أن بعض القصص القرآني يأخذ سمة (الاستقلال) في السورة، مثل: قصة يوسف (ع) ونوح (ع) في سورتي يوسف ونوح، إِلاَّ أن هذه السمة تظل امتداداً لعملية (التوظيف) المذكور، بحيث تستهل السورة أو تختتم بتعليقٍ من غير النثر القصصي، كما هو واضح.
والمهمّ، أن العنصر القصصي في القرآن - وهو يأخذ سمة (التوظيف) للسورة - تستغرقه حيناً سورة كاملة، وحيناً آخر (وهذا هو الغالب) يحّتل العنصرّ القصصي (جزءاً) منها: مع ملاحظة أن بعض (السور) تنتظمها أكثر من قصة، وبعضها الآخر تنتظمها قصة واحدة فحسب: كلاً حسب ما يتطلبه (الهدف الفكري) في السورة من عملية التوظيف القصصي.
ينبغي ألاَّ نغفل أيضاً عن الملاحظة المتصلة بحجم القصص القرآني من حيث تحديد (الجنس) الأدبي الذي يسمُها: وفقاً لتصوراتنا عن القصة الأرضية، حيث يمكننا أن نشطرها إلى ما هو (رواية)، مثل قصة يوسف وبعض قصص موسى، وإلى (قصة قصيرة) مثل غالبية القصص. كما يمكننا أن نلحظ نمطاً ثالثاً ينتسب إلى الشكل الذي نألفه عن (الحكاية). والمهّم ليس هو تحديد ذلك، مادام (التفرّد) - كما سبق القول - هو الذي يطبع القصص القرآنية، ويرغمنا على عدم استخدام أدوات النقد المألوفة في هذا الصدد، بل يعنينا فحسب أن نتعرّف خصائص (التفرد) المذكور ومساهمته الفنية العظيمة في إحداث التأثير المنشود، وهو هدف الفن بشكلٍ عام.
إننا لو وقفنا - على سبيل المثال - على قصة موسى (ع) في سورة (الشعراء)، لوجدناها تتناول حياة (طولية) لبطلها، حيث استغرقت الشطر الأكبر من حياة البطل: منذ إلقائه في اليمّ، فالتقاطه، فتسريحه، فدخوله المدينة وقتله أحد المتخاصمين، فتوجّهه إلى مَدين ومساعدته للفتاتين، فزواجه من إحداهما، فنزول الوحي عليه، فذهابه إلى فرعون. أقول: لو أردنا أن نستخدم أدوات النقد القصصي الذي يحدّد حيناً مفهوم (الرواية) من حيث كونها تتناول (حياة طولية) للبطل، وحيناً آخر من حيث عدد (الكلمات) المستخدمة فيها، وحيناً ثالثاً من حيث كونها تتناول (بُعداً فكرياً) معقداً: مقابل القصة القصيرة التي تتناول (مقطعاً عرضياً) من حياة البطل، أو (موقفاً شعورياً مفرداً) بسيطاً من ذلك، أو عدداً محدوداً من (الكلمات)... إن أمثلة هذه المبادئ النقدية في دراسة القصة تظل متصلة بحجم الشكل الأدبي أو بأبعاده من (فكرٍ) أو (شعور)، وهي ذات
فائدة - دون أدنى شك - تحديد العمل الأدبي وتخصيص أشكاله بما يناسبها من استخدام العناصر الجمالية التي تساهم في إِحداث (الإثارة) لدى المتلّقي. بَيْد أن (الفائدة) المذكورة تبقى مرتبطة بالهدف الأخير الذي أشرنا إليه، وهو (الإثارة) وتوصيل (الأفكار) التي يستهدفها كاتب النص. وهذا يعني أن (الجنس) الأدبي يبقى خاضعاً ل- (الأفكار) لا غير. ومع إقرارنا بهذه الحقيقة حينئذٍ، لا نجد ضرورة أن نحدّد ما إِذا كانت قصة موسى المتقدمة تشكّل (رواية) أم أن القصص التي تتناول (مقطعاً عرضياً) من حياته - مثل قصصه مع فرعون في حادثة السحرة - ستشكل (قصة قصيرة)، مع ملاحظة أنّ نقّاد القصة ودارسيها يقدمون أشكالاً متفاوتة في تقسيم أحجامها إلى: رواية، قصة طويلة - قصيرة، قصة قصيرة، أُقصوصة، حكاية... إلخ.
إن أهم ما يستهدفه دارس الفن هو: ملاحظة (الطرائق) التي تظل أشدّ فاعلية في إحداث التأثير لدى القارئ، بغض النظر عن (الجنس) الذي سيفرّق بين أنماط الصياغة القصصية، لذلك سوف لن نُعنى بهذا الجانب في عرضنا السريع للقصة القرآنية الكريمة، كما لن نُعنى بالحديث عن غالبية الأدوات التي يتوفّر عليها الدارس للقصة الأرضية، بقدر ما نُعنى بتعريف مُجمل لخصائص القصة القرآنية وصلة ذلك بعمليات الاستجابة البشرية في تلقّيها للنصوص، مكتفين منها بتقديم بعض النماذج القصصية على نحوٍ يتناسب وحجم هذه الدراسة السريعة(١) .
ونبدأ ذلك بالحديث عن:
بناء القصة القرآنية
القصة بنحوٍ عام تخضع - كما نعرف - لأبنية مختلفة. فهناك الشكل المألوف الذي يُعَرض عبر (بداية) هادئة تتطوّر الحوادث بعدها حتى تصل إلى (الذروة)، ثم تنحدر إلى (نهايتها). هناك القصة النفسية التي ظهرت، بأوضح صورها، في العقد الثالث من هذا القرن، مُفيدةً (من مكتشفات علوم النفس) في صياغة الأبنية غير الخاضعة لمنطق الظواهر الخارجية، بقدر خضوعها لما يُسمّى ب- (المجال النفسي)، ثم تطورت بعد الحرب الثانية إلى أبنية أكثر تحرّراً من سابقتها، حتى وصلت إلى أعقد الصيغ في سنواتنا المعاصرة. بَيْد أن (البُعد النفسي) في الحالات جميعاً، يظلّ هو المتحكّم - الواقع عبر أحدث أشكال القصة، حتى تسرّبه في أشكال القصة الموروثة أيضاً.
أما فيما يتصل بالقصة القرآنية، فإن البُعد النفسي المذكور يظل هو الطابع الجمالي لها، مادامت العمليات النفسية هي الإفراز الذي يحدّد نمط البناء، فيما لا يبقى للهيكل القصصي الموروث أو الحديث أيّما تميّز أو تفاضل إلاَّ بقدر إفصاحه عن البعد النفسي لأحداث القصة ومواقفها. المهم (كما سبق الحديث عن السورة القرآنية أيضاً) أن للقصة القرآنية عمارة خاصة تتواصل جزئياتها بنحو من التلاحم الحيّ من مقدمتها ووسطها ونهايتها. بحيث تُصبح كل جزئية إنماءً لسابقتها، أو مفصّلة لها، أو مسبّبة عنها، أو مُجانسة لها: في خضوعها للخيط (الفكري) الذي تستهدفه القصة: بغض النظر عن هيكلها المنتسب إلى شكلٍ موروث أو معاصر.
ولنتقدم بنموذج:
قصة طالوت:
قصة طالوت في سورة (البقرة) تتحدّث عن جماعة من وجهاء الإسرائيليين، تقدموا ذات يومٍ بطلبٍ إلى أحد أنبيائهم، بأن يرسل الله إليهم شخصيّة عسكرية ينضوون تحت لوائها لتخليصهم من الذلّ الذي لحقهم من تشريدٍ وسبيٍ وغيرهما. إِلاَّ أن نبيّهم شكّك بصدق ادعائهم الذاهب إلى أنهم مستعدون للقتال. لكنهم أكّدوا عليه استعدادهم في هذا المجال.
وهنا( قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً ) ، لكنَّهم اعترضوا عليه بأن القائد المذكور لم ينتسب لأسرة مالكة من سلالتهم ولم يُؤت سعةً من المال، فأجابهم النبيّ بأن الله منحه سعة في الجسم والعلم: فوافقوا على ذلك بعد أن طلبوا تقديم دليل إعجازي عليه، فقال لهم نبيّهم:( إِنّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِن رَبّكُمْ وَبَقِيّةٌ مِمّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلاَئِكَةُ ) عندها التحق الإسرائيليون به، إلاَّ أن القائد عرّضهم لاختبار إلهيّ قبل وصولهم إلى ساحة القتال عند مرورهم على (نهر)، فأمرهم بعدم الشرب إلاَّ بغرفة يد، ولكنَّهم تمرّدوا عليه إلاَّ قليلاً. وعندما وصلوا إلى ساحة القتال، جبنوا عن ذلك وتمرّدوا من جديد قائلين:( لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ) ، لكن القليل من جيش طالوت ثبتوا في المعركة هاتفين( كَمْ مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ ) ، وهزموهم في نهاية المطاف، وكان (داود) هو الذي تولّى قيادة المعركة وقتل (جالوت)، وانتهت المعركة.
هذا هو ملخّص القصة التي عرضتها السورة.. ولكن كيف تمّ البناءُ الفنيّ لها ؟ لقد بدأت القصة من (وسط) الأحداث، لا من (بدايتها) التي يقتضيها التسلسل الموضوعي، إنها بدأت بهذا النحو:،( أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) .. إلى هنا: القارئ لا يعرف سبباً لهذه المطالبة بالقائد. لكننا حين نتابع النص، نتعرّف ذلك. لقد أجابهم النبيّ:( قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ) .
إذن، السبب هو أن الإسرائيليين استذلهم أحد الجبابرة، فطلبوا من نبيّهم أن ينقذهم منه. وهذا يعني أن الحادثة ينبغي أن تبدأ من قضية استدلال الإسرائيليين، وليس من (طلبهم) الإنقاذ... فما هو السرّ الفني وراء هذه (البداية) القصصية؟
إن لكل (بداية) قصصية مسوّغ نفسي، والمسوغ هنا أن القصة جاءت في سياق عرض المواقف المشينة للإسرائيليين، حيث استعرضت ذلك سورةُ البقرة في عشرات من الآيات القرآنية المتصلة بهذا الجانب: من حيث تمردهم وكذبهم ونبذهم للعهود وجبنهم الله، وحينئذٍ فإن التقاط (الحدث) أو (الموقف) حينما (تُبدأ) به القصة من هذه الزاوية أو تلك، إنما يعني أهميته التي يستهدفها النص. فالنص لا يريد التركيز على استدلالهم بقدر ما يريد التركيز على فضح (الكذب) في مواقفهم، ولذلك بدأ بتسليط الضوء على هذا الجانب، مشدّداً - من ثم - على إبراز الحوار الذي تضمن إدّعاءً بالحرص على القتال.
وما أن بدأت القصة بهذا الموقف حتى ارتدت إلى أول الحادثة، فذكرت تشريد الإسرائيليين. ثم عَبَرت الحوادث لترسم لنا (نهاية) مواقفهم، متمثلة في هذا التعقيب( فَلَمّ
كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلّوْا إِلاّ قَلِيلاً ) . فالقصّة قرّرت سلفاً - قبل أن تذكر لنا تفاصيل سلوكهم فيما بعد - بأن الإسرائيليين تولّوا عن القتال إلاَّ قليلاً منهم. وهنا يثار السؤال: لماذا أعطت القصة النتيجة قبل مقدماتها؟
أهمية البناء الهندسي للقصة تتمثل في هذا التقطيع للحوادث وللزمن، ثم وصل ذلك عبر قنوات فنيّة تتضح من خلالها دلالةُ ما عنيناه ب- (التلاحم) العضوي بين أجزاء القصة.
إن تشكيك نبيّهم وإعطاء النتيجة قبل مقدماتها ينطوي على مهمّة فنية هي (إنماء) الحدث، أي: جعل القارئ يتهيّأ ذهنياً، من خلال التشكيك بصدق الإسرائيليين، بحيث يجد (جواباً) على ذلك التشكيك في أحداث لاحقة من القصة. كما أن تعقيب القصة - من خلال ذهابها إلى أنهم تولّوا إِلاَّ قليلاً، أخذ على عاتقه إِنماء (الحدث) أيضاً، حيث جاءت الوقائع التي سردتها القصة فيما بعد - مثل اعتراضهم على طالوت، تمردهم في حادثة شرب الماء من النهر، جبنهم عن مواجهة جيش جالوت - جاءت هذه الوقائع (جواباً) تفصيلياً على تلك المقدمة الإجمالية التي لوّحت بها القصة. فهاهم الإسرائيليون (يتولّون) عن القتال كما قالت المقدمة، وهاهم القليل منهم كما قالت المقدمة، يتقدم إلى القتال.. إذن، جاءت (بداية) القصة مرتبطة بوسطها ونهايتها: من خلال هذا (التقطيع) للحوادث و(وصلها) من جديد على النحو الذي لحظناه.
أما من حيث تلاحم الجزئيات ذاتها، فهذا ما يمكن ملاحظته أيضاً، فمثلاً نجد أن الإسرائيليين اعترضوا على طالوت بعدم توفّر سمتين لديه، هما: السلالة العسكرية والمال، إلاَّ أن القصة وازنت ذلك هندسياً بتقديم سمتين أيضاً، يعوّضان عن السمتين الأوليين، وهما: السعة في الجسم والعلم، مع ملاحظة سخف المطالبة الإسرائيلية ووجاهة التعويض الذي ألمح به نبيّهم.
(التابوت) أيضاً، يجسّم واحداً من عمليات (التوازي) الهندسي بين خطوط البناء. فالمعروف أن (التابوت) الذي قدمته القصة دليلاً حسياً على صدق نبيّهم في إرسال طالوت ملكاً، هذا التابوت بما فيه من (سكينة)( وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آَلُ مُوسَى وَآَلُ هَارُونَ ) يظل متجانساً مع (تجارب الإسرائيليين) حيال التابوت الذي كان ذات يوم (كما تقول النصوص المفسِّرة) مِلْكاً لهم يستفتحون به في المعارك، وكان هو المنقذ لموسى من فرعون، كما أن (البقية مما ترك آل موسى وهارون) من الألواح أو العصا أو الدرع أو الملابس - على اختلاف التفسير الوارد في تحديدها -... كل أولئك يشكّل أمراً له أهميته وتقديسه في مشاعر الإسرائيليين، بخاصة أنها تُستحضر بعد غيابها عنهم: عقاباً على سلوكهم المَشين.
إذن: ثَمَّة (توازن هندسي) بين داخل المشاعر الإسرائيلية وبين الرسم للبيئة الصناعية، بين (التابوت) وبين (المشاعر)
المتجانسة مع البيئة المذكورة.
هناك تجانس ثالث أيضاً بين (البيئة الجغرافية) للحدث، وهي (النهر) الذي (فصل) طالوتُ من خلاله بالجنود، وبين (البحرية) التي (فصلت) هؤلاء الإسرائيليين الذين قالوا:( لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ ) ب- (القليل) الّذين ردّد( كَمْ مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ ) .
وهناك تجانس رابع بين الفئة القليلة التي هتفت:( وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ) وبين نتائج المعركة التي حدّدتها القصةُ بقولها( فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ ) .
إذن: التجانس والتلاحم والتنامي بين أجزاء القصة منذ بدايتها وحتى نهايتها يظل على نحو من (الإحكام) الهندسي، بحيث يلحظ جماليته الفائقة كلّ مَن له أدنى تذوّق من تجارب القصة.
وهذا كله من حيث (عمارة) المواقف والأحداث.
أمّا من حيث (انتقاء) ذلك، اختزالاً أو تفصيلاً، فله مساهمته الجمالية الفائقة أيضاً في (عمارة) القصة. مثلاً: القصة لم تحدد لنا زمان هذه الواقعة، واكتفت من ذلك بالقول بأنها حدثت في زمان من بعد موسى:( أَلَمْ تَرَ إلى الْمَلاَءِ مِن بَنَي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى ) . أما متى حدث ؟ وفي زمن أي نبيٍّ من أنبيائهم ؟ هذا ما لم تُشر القصةُ إليه، فلماذا؟
السرّ في ذلك عائدٌ إلى أن القصة تستهدف التركيز على دلالة خاصة، هي: أن الشخصية الإسرائيلية تظل - في كل زمان ومكان - مريضة، كاذبة، جبانة، مترددة، إلخ.. إنها حتى (من بعد موسى) بقيت على نفس الطابع الملتوي من السلوك فيما لا سبيل إلى إصلاحه، فهي (في زمان موسى) أتعبته كثيراً: من خلال المواقف التي سردتها سورة البقرة قبل هذه القصة، وها هي (من بعد موسى) أيضاً تمارس نفس السلوك. إذن: لهذا التضبيب المتصل بزمان الحادثة، والتنويه إلى أنها تمت من بعد موسى، له مغزاه الفنّي من حيث عمارة القصة.
أيضاً: يُلاحَظ أن القصة ما أن سردت لنا أوصاف (التابوت) حتى انتقلت مباشرة إلى ساحة المعركة:( فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ ) ، دون أن تذكر لنا (موافقة) الإسرائيليين على هذا المعجز، مما جعلتنا - نحن القرّاء - نستنتج موافقتهم على ذلك، بخاصة أنهم اعترضوا على طالوت بالسمتين اللتين أشرنا إليهما. المهم، أن لهذا الاختزال أهميته البنائية في القصة، مادام الهدف هو إبراز تجربة (تمرّدهم) و(كذبهم)، وليس إبراز مجرد (الموافقة)، لأنهم طالما (يوافقون) على شيء ثم (ينقضونه).
أيضاً: يُلاحَظ أن القصة أبرزت شخصية (جالوت) ومن بعده (داود) دون أن تمهّد لأيّ منهما سابقاً، بل أبرزتهما (قائدين)، أحدهما: مع الفئة المؤمنة (داود)، والآخر: قائد جيش
العدوّ، حيث استخلص القارئ أن لشخصية (جالوت) صلة بالاستدلال الذي لحق الإسرائيليين.
وبهذا الاحتفاظ بشخصية (جالوت) - وداود أيضاً - والكشف عنهما في نهاية القصة، أهميته من حيث عمارة القصة (ما يتصل بعملية الاقتصاد في السرد) من جانب، وبعناصر فنية أخرى لها إسهامها في جمالية البناء القصصي من جانب آخر، ونعني بها عناصر:
المباغتة والمماطلة والتشويق:
المألوف (في لغة الأدب القصصي) أن لكل من: (المباغتة): التي تعني مواجهة القارئ بموقف أو حدث مفاجئ، و(المماطلة): التي تعني الاحتفاظ بسرّ لم يُكشف إلاّ بعد حين، و(التشويق): الذي يعني شدَّ القارئ إلى متابعة (ماذا سيحدث). أقول: المألوف أنّ للعناصر المتقدمة أثرها في جمالية القصة، ليس من حيث استثارتها للقارئ فحسب، بل من حيث إفادتها في تعميق الدلالة التي يستهدفها النص، فضلاً عن مساهمتها في (تجميل) العمارة القصصية أساساً.
وإليك نماذج قصِصية في هذا الصدد، منها:
قصة إبراهيم:
فيما يتصل بعنصر (المباغتة)، يمكننا أن نقدّم قصة إبراهيمعليهالسلام التي وردت في سورة (الأنبياء)، عبر واقعة تهشيمه للأصنام وإبقاء كبيرها، نموذجاً واضحاً لعنصر (المباغتة). إن هذا العنصر يُرسم حيناً بنحو يصاحبه شيء من الدهشة والاستغراب مع (توقّعنا) لحدوثه، وحيناً آخر، يرسم بنحو (مفاجئ) لا يكاد (يُتوقع). طبيعياً، أن كلّ شيء (مُتوقع): مادمنا مقتنعين بالإعجاز، إلاَّ أننا ننطلق في هذا الاتجاه من خلال منطق الأحداث ذاتها، سواء أكانت مصحوبة بما هو عادي أو بما هو معجز. كما ينبغي أن نفرّق بين (مُباغتة) قد هيّأ النصُّ أذهاننا سلفاً إلى حدوثها، وبين (مباغتة) لم تكن في الحسبان. كل هذه المستويات يمكننا أن نلحظها في قصة إبراهيم المذكورة. لقد مهّدت هذه القصةُ أذهاننا إلى أن الطغاة سوف يلحقون الأذى بإبراهيمعليهالسلام نتيجة تهشيمه لأصنامهم:
( قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ * قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ * قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ) لقد وسموه ب- (الظلم)، وهذا أول مؤشر على أنهم يفكرون بإلحاق الأذى به. ثم اقتراحهم بإحضاره أمام الجمهور لإدانته، يفصح عن (توقعنا) بأن (عقاباً) كبير الحجم قد يطاله: كأن يكون قتلاً أو سجناً أو ضرباً مثلاً.. لكن مع هذا التوقع، تبدأ القصة برسم منحىً فنيّ في بناء الأحداث والمواقف، بحيث تنقل القارئ إلى
(توقع) مضاد للتوقع السابق، وهو: إمكانية غض النظر عن معاقبة إبراهيم، وهذا ما يوحى به الحوار الدائر بينه وبين القوم.
( قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ * قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ * فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ * ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ) .
إن هذا الحوار الحيّ المُمتع يفصح عن أن القوم أحسوا ببعض الخجل، بل أحسوا بخجل كبير أمام أنفسهم حينما خاطبوها بأنها هي الظالمة، وحينما خفضوا رؤوسهم من الخجل قائلين:( لَقَدْ عَلِمْتَ - يا إبراهيم -مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ) ، أي أنهم اقرّوا بمهزلة آلهتهم، وإلى أنها لا تملك فاعلية النطق، وحينئذٍ (يتوقّع) القارئ أنهم سوف يتراجعون عن قرار الإدانة والمعاقبة.
هنا ينبغي أن ينتبه القارئ إلى جمالية الأداء القصصي من حيث إِثارته للقارئ وعدم رسوّه على قرار ثابت: فبينا (يتوقّع) إِدانة إبراهيم، إِذا به (يتوقّع) الإفراج عنه. لكن ما أن يتوقّع (الإفراج) عن ذلك، حتى يُصدم ب- (مباغتة) تضاد موقعه الأخير، وترتد به إلى توقّعه السابق، وهو: العقاب، لكن ليس على نحو ما (توقّعه) من ضربٍ أو سجنٍ أو قتل اعتيادي، بل - وهذا هو عنصر المباغتة - على نحو لم يدُر في خلده:( قَالُوا: حَرِّقُوهُ... ) .
إذن: يُفاجَأ القارئ ب- (عقاب) غير متوقّع، وهو: (الإحراق). جديداً ينبغي - من الزاوية الفنية - أن ننتبه إلى أهمية هذا التماوج بين توقّعات تتصاعد وتتهاوى من حين لآخر: توقّع بإنزال العقاب في (بداية) القصة، توقع بإزالة العقاب في (وسط) القصة، ثم (مباغتة) بإنزاله في لحظة (الإنارة) التي تنحدر القصة بعدها إلى نهايتها ؛ لأننا لحد الآن لم ننته من القصة، فلا تزال تنتظرنا (مباغتة) من النمط غير المتوقع في نهاية القصة.
قلنا: إن (المباغتة) قد تجيء مصحوبة بشيءٍ من الدهشة، مثل العقاب بعد توقعنا بإزالته عبر مناقشة القوم لإبراهيم، ثم قد تجيء بلا أن (نتوقع) حدوثها، مثل مباغتتنا بإحراق إبراهيم بعد أن كنا نتوقع عقاباً مثل: السجن أو الإعدام: ولكن ليس (الإحراق).
والآن نواجه (مباغتةً) من قسم ثالث، لا (يُتوقع) البتة، ولم يدر في الحسبان أبداً، ألا وهي: النهاية التي خُتمت بها القصة، وهي تقول:
( يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلَاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ ) .
هذه الواقعة، تجسّد أعلى ما يمكن تصوره من معنى (المباغتة)... فها هو إبراهيم مُلقىً في النار، والنار - في حالاتها غير المصحوبة بالإعجاز - تبقى ناراً لا شيئاً آخر، قد تنطفئ مثلاً...
لكنها لا تتحول إلى (برد وسلام).
أدرك القارئ - إِذن - جمالية الصياغة القرآنية الكريمة لعنصر (المباغتة) بمستوياتها الثلاثة في قصة واحدة، هي قصة إبراهيمعليهالسلام ، بما صاحبها من تماوجٍ ممتعٍ في عواطف القارئ في توقّعاته التي تصاعَدَ بها وتهاوى من حين لآخر، حتى انتهى به إلى النهاية التي لحظناها.
أما عنصر (المماطلة) أو (إرجاء المعلومات) - وهذا الأخير هو ما نفضّل استخدامه بدلاً من اللغة التي يستخدمها نقّاد القصة - هذا العنصر يمكننا أن نتلمسه بوضوح في قصة (أهل الكهف): من حيث احتفاظ القصة بالسرّ المتمثّل في عدد سنيّ أهل الكهف. فالقصة بدأت - كما نعرف - بهذا النحو:
( إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إلى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبّنَا آتِنَا مِن لّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً * فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً * ثُمّ بَعَثْنَاهُمْ... ) .
القارئ منذ بداية القصة يظل على إحاطة مجملة بزمان اللبث، لكنه يعرف أن اللبث هو (مجموعة من السنين - سنين عدداً). أمّا عددها المحدّد، فأمر احتفظت القصةُ به. القارئ - بطبيعة الحال - يظل على أشد الشوق لمعرفة السنين التي مكث فيها أصحاب الكهف. وكلّما توغّل مع أحداث القصة، فإن هذا السرّ يبقى على حاله، وحتى إن النزاع الذي دار بين مكتشفي الكهف لم يسعفه في معرفة سنيّ اللبث: بالرغم من أن القارئ يستطيع أن يستنتج بأن هناك (جيلاً) أو أكثر قد تصرّم بعد حادثة الكهف، بدليل أن النزاع الدائر بين مكتشفي الكهف يفصح عن وجود (فئة مؤمنة) اقترحت بناء مسجدٍ على أصحاب الكهف، مع أن المرحلة التي عاصرها أهل الكهف كانت متمحّضة للسلطة الظالمة وللجمهور المماثل لها أيضاً، وهذا يعني أن أعواماً طويلة قد تصرّمت، أو أن السلطة الحاكمة قد تبدّلت: بحيث سمحت للفئة المؤمنة بمثل هذا الاقتراح... ولكن مع ذلك لا يكاد القارئ يتعرّف أي تحديد للسنين في هذا الصدد، ويظلّ القارئ على تطلّعه المذكور لمعرفة ذلك، لحين اكتشاف القصة العدد المحدّد في (نهايتها) التي تقول:( وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاَثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً.. ) .
طبيعياً، أن هذا النمط الذي نطلق عليه مصطلح (إرجاء المعلومات)، ويُطلق عليه نقاد القصة (المماطلة)، يتّخذ أكثر من سمة في هذا الصدد - مثل عنصر المباغتة الذي تحدثنا عنه - فحيناً تحتفظ فيه القصة ب- (السر) لتكشفه في نهاية القصة كما لحظنا عن سنيّ أهل الكهف، وحيناً آخر لا تفصح عنه البتة، بل يظل (السر) على غموضه، وهذا ما يتصل بعدد أصحاب الكهف أنفسهم. فالقارئ يتطلع لمعرفة عددهم حينما تنبهّه القصة ذاتها إلى ذلك من خلال هذا الحوار:
( سَيَقُولُونَ ثَلاَثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَبّي أَعْلَمُ بِعِدّتِهِم مَا يَعْلَمُهُمْ إِلّا قَلِيلٌ ) .
إن القصة تردم أية إمكانية للتعرّف حينما تقرّر:( قُل رَبّي أَعْلَمُ ) ، ثم تجعل القارئ متشوقاً إلى المعرفة من جديد حينما تقرّر:( مَا يَعْلَمُهُمْ إِلّا قَلِيلٌ ) . وبهذا النحو (من إرجاء المعلومات) تحقق القصة إمتاعاً جمالياً للقارئ لا مجال للتحدث عنه الآن بقدر ما نستهدف الإشارة إلى أنه نمط آخر يحتفظ بالسر دون أن يعلن عنه في نهاية القصة. وهناك نمط ثالثٍ يتراوح بين النمطين المذكورين، وهو: تنبيه القارئ إلى وجود (سرٍّ) ما، وتَعِدَه (فنِّياً) بالكشف عنه في نهاية القصة، وهذا ما يتمثّل في قصة (موسى مع العالِم). فالقصة لا تكشف عن أسرار وخرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار إلاّ في ختام القصة، لكنها تَعِد القارئ (بطريقة فنية) بأن (السر) سيتضح في نهاية، وهذا ما يُفصح عنه (العالِم) في جوابه لموسى عندما طلب منه أن يتبعه:( قَالَ فإن اتّبَعْتَنِي فَلاَ تَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً ) ، أي: إن (العالِم) وعَدَ موسى (والقارئ أيضاً) بأن (يذكر) له أسرار الظواهر التي أراد أن يتعرّفها موسىعليهالسلام .
إذن: هناك ثلاثة أشكال من عنصر (المماطلة - إرجاء المعلومات) تستخدمها القصة القرآنية:
أحدها: عدم الاحتفاظ بالسر الذي نتعامل به مع القارئ.
والثاني: كشفه في نهاية القصة.
والثالث: الإعلان عن كشفه فيما بعد.
ولكل من هذه السمات أهميتها الجمالية في ميدان الاستجابة لدى القارئ.
وواضح أن (إرجاء المعلومات) بعامة، له أهميته في شدّ القارئ إلى متابعة القصة، إِلاَّ أن تنويعه بالمستويات الثلاثة له أهميته (الفكرية) أيضاً. فعدم إعطاء المعلومات أساساً - مثل عدد أصحاب الكهف - لم يكن من الضرورة معرفته، مادام المهم هو: اللجوء إلى الكهف، وليس عدد الملتجئين إليه، والإعلان عن إعطاء المعلومات فيما بعد - مثل أسرار خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار - له أهميته النفسية في صياغة السلوك الآدمي، من خلال التدريب على الصبر وعدم التعجّل في استكناه أمور تأخذ سبيلها إلى الظهور في الوقت المناسب.
وواضح أيضاً أن القصة سلكت منحىً بنائياً في غاية الخطورة، عندما (جانست) بين كلّ من شخصية القصة (موسى) وبين (القارئ)، فهي في الوقت الذي جعلت (القارئ) يستخلص من قصة موسى مع العالم أن الاصطبار على معرفة الأمور في الوقت المناسب هو السلوك الأمثل، اتجهت القصةُ في الآن ذاته إلى (تدريب) القارئ (عملياً) على تطبيق هذا السلوك، فجعلت القارئ يمارس بنفسه عملية (الاصطبار) على معرفة الأمور في وقتها المناسب، متجسداً ذلك في عدم إعطائه المعلومات المتصلة بمعرفة أسرار القتل والبناء والخرق إلاَّ في آخر القصة: مع ملاحظة أن القصة وعدته
بإعطاء ذلك، أي: أن القصة بإعطائها مثل هذا (الوعد) جعلت القارئ متطلعاً إلى معرفة السر، ثم أرجأت ذلك حتى يتدرّب القارئ على الصبر حيال ذلك. إنّ مثل هذه العمارية المُحكمة في القصة، لا يكاد يدركها القارئ العابر الذي يقرأ مجرّد قصة يستمتع بمعلوماتها ويتحسّس جماليتها، دون أن يدرك أسرار البناء القصصي المتسم بالإعجاز الفني، الذي يجمع إلى جمالية العرض أسراراً تتصل بكل من أبطال القصة وقرّائها في عمليات (الاستجابة) البشرية التي تستهدفها القصة قبل كل شيء.
بعامة، أن عناصر (المماطلة والتشويق والمباغتة) تظل متصلة بالبعد (الزمني) للقصة من حيث استباق الزمن وتمطيطه حيال القارئ، كما أن (تقطيع) الزمان على نحو ما لحظناه في قصة طالوت مثلاً، يظل متصلاً بالأسرار الكامنة وراء (بدايات) القصة ووسطها ونهايتها.
وهناك أسرار تتصل بطيّ الزمن وتضبيبه (أي جعله مبهماً) لدى البطل أو القارئ بحيث يساهم في جمالية البناء العماري للقصة، وهو أمر نتناوله تحت عنوان:
الزمان النفسي:
الزمان النفسي - كما لحظنا - يعني: تقطيع سلسلة الزمن من مجاله الموضوعي، وصياغته وفقاً (للمجال النفسي) الذي وقفنا على جانبٍ منه في انتقاء الحدث من وسطه أو نهايته، وفي إرجاء المعلومات المتصلة به إلى زمان آخر. أما الآن فنتحدث عن (طيّ) الزمن وتضبيبه في ميدان العمارة القصصية.
فيما يتصل بطيّ الزمان، يمكننا ملاحظة جملة من القصص التي تشدّد على هذا الجانب، ومنه مثلاً:
قصة أصحاب القرية:
في سورة ياسين، تواجهنا قصة أصحاب القرية التي جاءها المرسلون:( إِذْ أَرْسَلْنَا إليهم اثْنَيْنِ فَكَذّبُوهُمَا فَعَزّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنّا إِلَيْكُم مّرْسَلُونَ ) ثم جاء بطلٌ رابع:( وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَاقَوْمِ اتّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ) . هذا البطل بدأ بالنصيحة لقومه، مشيراً إليهم بأن يتبعوا المرسلين الثلاثة. بَيْد أن القصة وهي تنقل لنا نصائح هذا الرجل لقومه، إذا بها تنقلنا مباشرة من بيئة الحياة الدنيا إلى الجنة، قائلة على لسان هذا البطل مايلي:
( قِيلَ ادْخُلِ الْجَنّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ * بِمَا غَفَرَ لِي رَبّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ) .
إن هذه النقلة الزمنية من سياق النصائح التي قدّمها البطل لقومه إلى موقع ( الجنة )، ومتابعته توجيه الكلام إلى قومه وهو في الجنة، هذه النقلة الزمنية تظل واحداً من أسرار البناء الفني للقصة ينبغي أن نتابعها بعناية بالغة.
تُرى لماذا نقلت القصةُ هذا البطل من موقعه الدنيوي إلى موقعه الأخروي، مع أنه لا يزال يتحدّث مع قومه ؟ السرّ في ذلك يكمن في استهداف النص تنبيه القارئ إلى مفروضية الجزاء المترتّب على ( الجهاد ) في سبيل الله، وهو: الجنة. كما يتمثّل في الكشف عن مصير البطل الذي جاء ينصح قومه باتباع الرسل. فالقصة لا تنقل لنا شيئاً عن مصير الأبطال الثلاثة الذين تقدّموه، ولا تنقل لنا مصير البطل الرابع، إنها تقول لنا: إن المرسلين الأربعة قد مارسوا وظيفتهم، وإلى أن الجمهور قد ( كذّبهم). ولكن ماذا حدث بعد ذلك ؟ هذا ما لم تتحدّث القصةُ عنه.
لكننا - نحن القرّاء - من خلال هذه النقلة التي لحظناها عن البطل الرابع، استطعنا أن نستنتج بأن هذا البطل قد استشهد؛ وإلاَّ لم يُقل له:( ادْخُلِ الْجَنَّةَ ) . وفهمنا أن الرسل الثلاثة من الممكن أن يكونوا قد واجهوا نفس المصير. كما نستخلص قيمة فكرية تتصل بنقاء الشخصية المؤمنة ومحبّتها لقومها بالرغم من إيذائهم إيّاها... فهذا البطل الذي استشُهد، لابدّ أن يكون القوم قد أوجعوه ضرباً، أو ركلوه بأرجلهم - كما تقول بعض النصوص المفسّرة - أو قتلوه مباشرةً. لكنه مع ذلك، يواصل الإعلان عن محبته لقومه، حيث قال ( وهو في الجنة ):( يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ * بِمَا غَفَرَ لِي رَبّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ) إنه، وهو في الجنة، يتمنّى أن يعرف قومّه مصيرَه إلى الجنة وتكريمه من قِبَل الله تعالى. إذن: كم هو نقيّ في أعماقه ؟ كم هو محبّ لقومه بالرغم من قتلهم إيّاه. إنه يتمنّى لو يرعوون، لو يتّجهون إلى الإيمان، ليظفروا بنفس الجنّة التي ظفر بها.
إن ( طيّ ) الزمن بهذا النحو الذي لحظناه، قد تمّ وفق رسمٍ فنيّ بالغ المدى، حيث نقلت القصةُ البطل إلى ( الجنة )، ثم عادت إلى الأرض من جديد لتقول لنا:( وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِنَ السّماءِ وَمَا كُنّا مُنزِلِينَ * إِن كَانَتْ إِلّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ) . كان من الممكن أن تقول لنا القصة: ( إن البطل قتله القوم فاستحق بذلك الجنّة. وإن قومه قد أنزلنا عليهم العذاب فجعلناهم خامدين )، لكن القصة سلكت منحىً فنياً بالغ الخطورة، حينما تعاملت مع عنصر ( الزمن ) بهذا النحو الذي عَبَرَت به إلى ( اليوم الآخر )، وعادت به إلى الحياة الدنيا لتواصل بقية وقائع القصة، محقّقة بذلك أكثر من هدف فنّي، هو: استشهاد البطل، استشهاد الرسل، محبّته لقومه حتى وهو في الجنّة، مصيره الحتمي إلى الجنة، ثم: المصير الدنيوي للمكذّبين، فضلاً عن مصيرهم الأخروي.
وإذا كانت هذه القصة تتعامل مع ( طيّ ) الزمان من خلال نقله من بيئة دنيوية إلى بيئة
أخروية، فهناك نمط آخر من ( الطيّ ) يتم داخل البيئة الدنيوية نفسها، متمثِّلاً في:
قصة سليمان:
قصة سليمان تتحدّث ( في سورة النمل ) عن الطائر الذي تفقدّه سليمان، حيث كان قد ذهب لمهمة هي إخبار سليمان عن وجود ملِكة في ( سبأ )، تعبد - هي وقومها - الشمس. وعندما أمر سليمان بإحضار عرش الملكة، ( قَالَ عِفْرِيتٌ مّنَ الْجِنّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مّقَامِك )، ولكن( قَالَ الّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمّا رَآهُ مُسْتَقِرّاً عِندَهُ قَالَ هذَا مِن فَضْلِ رَبّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَم أَكْفُرُ ) .
الهدف الفكري من القصة واضحٌ تماماً من خلال الفقرة التي عقّب عليها سليمان:( هذَا مِن فَضْلِ رَبّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَم أَكْفُرُ ) . إِلاَّ أننا نستهدف من الوقوف عند القصة المذكورة، ملاحظة ( البُعد الزمني ) فيها، وطريقة ( الطيّ ) التي تعاملت القصة فيها مع عنصر ( الزمن ). فالزمن هنا قد ( طُوي ) في لحظة طرف لا أكثر، مع أن البطل الذي نهض بهذه المهمة هو من ( البشر )، وليس من ( الجن ) الذي يملك إمكانات من التحرك السريع الذي لا يملكه البشر. ومع ذلك تم ( الإعجاز ) على يد ( بشرٍ ) عنده ( علمٌ من الكتاب )، في حين أن ( الجن ) لم يستطع تحقيق ذلك إلاَّ في ( ساعات )، حيث اقترح على ( سليمان ) بإحضاره قبل أن يقوم من مقامه، في الوقت الذي استطاع ( البشر ) أن يحقّقه في ( ثوانٍ ) لا في (ساعات).
هذا يعني أن القصة تريد أن تقول لنا: إنّ الشخصية الآدمية لو أخلصت في سلوكها العبادي، لاستطاعت أن تحقّق ما لم يستطع تحقيقه حتى مَن ينتسب إلى ( الجن ) الذي يمتلك إمكانات لا يمتلكها البشر. مضافاً لذلك، فان قضية شكر النِعَم أو تجاهلها، تظل أيضاً مستهدفة بوضوح من خلال هذه القصة التي عبّر عنها سليمان صراحةً لا ضمناً.
إذن، التعامل مع الزمن من خلال ( طيّه ) من بيئةٍ دنيوية إلى مثلها، أو من بيئة دنيوية إلى أخروية، يظل - في الحالتين - مرتبطاً بالكشف عن أهداف ( فكرية ) لا تحدّثنا القصة عنه مباشرة، بل من خلال ( مبنىً فنّي ) خاص يحقّق كلاًّ من الإمتاع الجمالي والفكري عند القارئ.
هناك نمط آخر من التعامل من ( الزمن )، هو: طريقة ( الإحساس ) به. وهذه الطريقة لها أهميتها الفنية أيضاً، من حيث ( إبهام ) الزمن وتضبيبه لدى أبطال القصة، وليس لدى القارئ. ففي قصة سليمان ذاتها نجد أن ( الملكية ) افتقدت الإحساس بالزمان ( وبالمكان أيضاً )، ثم اهتدت إليه، وكانت النتيجة أنها أسلمت لرب العالمين. ولكن لننتقل إلى أبطال آخرين في قصة أخرى، هي:
قصة أصحاب الكهف:
في هذه القصة نجد أن أبطال الكهف قد افتقدوا ( الإحساس بالزمن ) تماماً. تُرى ما هو المُعطى الفني لمثل هذه الصياغة لعنصر الزمن وتضبيبه في إحساس الأبطال ؟ لنقرأ أولاً:
( وَكَذلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إلى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيّهَا أَزْكَى طَعَاماً.. ) .
لقد كشف هذا الحوار عن غموض المدة الزمنية لمكوثهم في الكهف، فالحوار الأول( كَمْ لَبِثْتُمْ ) لا يوحي بقصر المدة أو طولها. ثم جاء الحوار الثاني موحياً بأن المدة قصيرة جداً( قَالُوا لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ) . غير أن الحوار الثالث ( رَبّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ) جعل الإحساس بالزمن لدى الأبطال ملفَّعاً بالغموض من جديد، حتى إن القصة ( من الزاوية الفنية ) قدّمت لنا ممارسة تطبيقية للأبطال، تكشف عن ( غموض ) الزمن لديهم.
وهذه الممارسة تتمثّل في الواقعة التالية:( فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إلى الْمَدِينَةِ... ) ، فلو لم يكن الأمر غامضاً بالنسبة إليهم، لتردّدوا في استخدام العملة النقدية التي كانت لديهم، ولتردّدوا في الاقتراح بشراء الطعام الزكي، بمعنى أنهم لا يزالون يعيشون الإحساس بزمنهم وبيئتهم التي عهدوها، لأن إرسال العملة المألوفة يوحي بأن الزمن قصيرٌ في تصورهم، كما أن شراء الطعام الزكي يقترن ببيئة ( الكفر ) التي تتطلّب بحثاً عن طعام زكيّ بالقياس إلى ركام الأطعمة غير الزكية.
إن هذا الغموض الزمني في أحاسيسهم يدعو إلى الدهشة في حقيقة الأمر. والسبب في ذلك يعود إلى أن القصة نفسها رسمت لنا شيئاً من ملامحهم حينما قالت:( لَوِ اطّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلّيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً ) . ولو رجعنا إلى النصوص المفسّرة، لوجدنا أنها تتردّد بين الذهاب إلى أن سمة ( الخوف ) و( الفرار ) منهم عائدة إلى ملامح الأبطال أنفسهم، من حيث إطالة شعورهم وأظافرهم، أو أنها عائدة إلى استيحاش الموقع، أي: الكهف.
واستبعد بعض المفسرين أن يكون الخوف والفرار ناتجاً من إطالة شعورهم وأظافرهم ؛ لأنه لو كان الأمر كذلك، لما قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم. غير أن هذا الاستنتاج يردّه: أن الفرار والخوف لو كان من جهة ( الكهف ) لقال النص ( لوليت ( منه ) فراراً ولمُلئت ( منه ) رعباً ). أما أن النص قال: ( منهم ) بدلاً من ( منه )، فهذا يعني أن الاستيحاش عائد إلى ( الأبطال ) وليس إلى ( الكهف ). ولكن هذا الاستنتاج الأخير يتنافى مع قولهم ( لبثنا يوماً أو بعض يوم )... ! إذن: ماذا يمكن أن نستنتج من ذلك كله ؟
لا شيء غير ( الغموض ) هو الذي يخامر ( إحساس الأبطال بالزمن ). طبيعياً من الممكن
أن يكون السائل الذي قال( لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ) غير منتبه إلى ملامحه الجسمية، ومن الممكن أن يكون القائل بعد ذلك( رَبّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ) ، قد انتبه إلى هذا الجانب، وتحسّس بأن هناك مدة طويلة قطعاً، لكنّه لم يستطع أن يقدّرها تحديداً، ولذلك اقترح إرسال العملة النقدية والتحفّظ في شراء الطعام ؛ تعبيراً عن إحساسه الغامض بالزمن.
المهم، أن القارئ يثير مثل هذا السؤال: ترى ماذا يمكننا أن نستخلص من هذا ( الغموض ) الذي رسمته القصة لأبطالها ؟
في تصوّرنا أن القضية تظل متصلة برسم ( الإعجاز ) الذي الذي تستهدفه القصة، من حيث ترسيخه في أحاسيس الأبطال، بغية حملهم في نهاية المطاف إلى العودة للكهف... وهذا ما حصل فعلاً... غير أن هذا يظل واحداً من مجموعة أسباب فنية لابدّ من الوقوف عليها مادمنا في صدد تعبير معجزٍ وليس حيال مجرد قصة يكتبها بشر.
الملاحظ في شخصية سليمان - التي تقدّم الحديث عنها - أنها بالرغم من توفير قوى الجن والإنس والطير لها، نجدها لم تُحط علماً بسفر الطائر الذي توجّه إلى ( سبأ )، والملاحظ أيضاً أن موسى لم يُحط علماً بأسرار القتل والبناء والخرق، والملاحظ في سائر القصص أمثلة هذه الأسرار التي تحتفظ بها السماء ولا تظهرها حتى للشخصيات المتقدمة... فإذا نقلنا هذه القضية إلى أبطال ( عاديين ) مثل أصحاب الكهف، للحظنا أن عدم رسمهم ( أبطالاً مطلقين )، أي لا يشوبهم نقص في المعلومات، يظل محكوماً بالأولوية بالقياس إلى ( الأنبياء ). وهذا يعني أن القصة تستهدف تركيز مثل هذه المفاهيم، ليس في أذهاننا فحسب، بل في أذهان الأبطال أنفسهم، أيّاً كانوا: أنبياء أم عاديين.
إذن، الهدف الأول من هذا الرسم هو: تحسيس الأبطال بقصورهم بشكل عام.
ثانياً: أن نفس هذا ( الغموض ) يكشف عن جانبٍ من العمليات النفسية في السلوك الآدمي، ونعني به: ( التوتر ) وضرورته في العمل العبادي، من حيث كونه يُفضى إلى الوصول للحقيقة. فالكائن الآدمي - أيّاً كان - يظل عرضةً لصراع وتوترات شتَّى، تتطلَّب منه أن يتجاوزها من جانب وأن يتحمَّلها من جانب آخر: اتساقاً مع طبيعة المهمة الخلافية في الأرض. فأبطال الكهف وهم يتجهون إلى ( العزلة )، قد لا يصاحبهم اطمئنان كامل بتوفر البيئة التي تضمن لهم طموحاتهم في هذا الصدد، كما أنهم لا يعرفون مدى ( العناية الإلهية ) التي صاحبت دخولهم إلى الكهف من حسباننا أياهم أيقاظاً وهم رقود، وتقليبهم ذات اليمين والشمال، وتزاور الشمس عنهم ذات اليمين عند الطلوع، وقرضهم ذات الشمال عند الغروب... كل هذه المستويات من ( العناية )، من الممكن إلاَّ يكون أصحاب الكهف قد انتبهوا إليها، وهو أمرٌ تُعلِن عنه محاوراتهم المذكورة، ممّا يدفعهم - بعد معرفة حقائق الأمور - إلى المزيد من ( الشكر ) لواهب النِعم الذي يغدقه
على الآدميين وهم لم يحيطوا بها علماً.
مضافاً إلى ذلك، ما سبق أن قلناه من أن ذلك سيدفعهم، عندما يواجهون الحياة من جديد، إلى أن يفضّلوا بيئة الله التي لا تضارعها بيئة الحياة الدنيا.
إذن: أمكننا أن نستخلص جملة من الدلالات الفنية لهذا الرسم المتصل بتضبيب الزمن في أحاسيس الأبطال، وانعكاساته على سلوك ( القارئ ) الذي سيفيد منها في ( تعديل ) السلوك.
بعامة، ما قدّمناه من عرضٍ سريع لظاهرة الزمن وسواه من الظواهر المتصلة بالتشويق والمماطلة والمباغتة، وما قدّمنا من التلاحم العضوي بين أجزاء القصة...، كل ذلك يظل متصلاً بواحدٍ من عناصر ( الشكل القصصي )، وهو:البناء العماري للقصة.
والآن نتقدّم إلى مفردات البناء القصصي، وفي مقدمتها، عنصر:
الأبطال في القصة:
الأبطال - أو الشخصيات - يشكّلون الحركة الحيّة في القصة كما هو واضح، فالأحداث والبيئات لا قيمة لها إلاَّ بقدر وجود " الحركة الإنسانية " عليها. وحيال هذا فإن انتقاء الشخصية وطريقة رسمها وإلقاء الأدوار عليها، يظل في الصميم من حركة القصة وحيويّتها. وبما أن تجسيد " الهدف الفكري " في النص، لا يتحدد إلاَّ بقدر تحديد الشخصية ذاتها، حينئذٍ فإن الأبطال لابد أن يتحرّكوا طبقاً لما يتطلّبه الهدف الفكري من بطلٍ واحدٍ أو أكثر، وبطلٍ فردي أو جمعي، مبهمٍ أو محدد، نامٍ أم مسطح، رئيس أو ثانوي، بشري أو غيره... إلخ. كل هذه التحديدات للشخصية نجدها بوضوح في القصص القرآني، حيث تُرسَم بإحكام ودقة واقتصاد لافت للانتباه.
وأول ما يلفت الانتباه هو: ( عدد ) الأبطال الذين تحتاجهم القصة. فالمعروف في القصة البشرية أن القصة القصيرة - مثلاً - ينتظمها عدد محدَّد من الشخصيات يتناسب وحجم القصة ومواقفها البسيطة المفردة، في حين أن الرواية يتسع عدد أبطالها ويتنوّعون تبعاً لما تتطلبه ( وجهة النظر ) القصصية في هذا الصدد. أما في القصة القرآنية، فإن ( الإحكام ) العددي للأبطال، يأخذ أقصى ما نتوقّعه من تحديد لهم، سواء أكان ذلك في العدد أو في رسم ملامحهم الداخلية والخارجية. ولنأخذ نموذجاً في هذا الصدد:
قصة آدمعليهالسلام :
إنَّ أول قصة تواجهنا في القرآن هي قصة: المولد البشري متمثِّلاً في آدمعليهالسلام ، إذ تبدأ بهذا
النحو:
( وَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدّسُ لَكَ قَالَ إِنّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ * وَعَلّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلّهَا ثُمّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هؤُلاَءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لّكُمْ إِنّي أَعْلَمُ غَيْبَ السّماواتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ * وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوْا لآِدَمَ... ) ،( وَقُلْنَا يَاآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتَما وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشّجَرَةَ... ) ،( فَأَزَلّهُمَا الشّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمّا كَانَا فِيهِ ) .
هذه هي تجربة المولد البشري من حيث جعْله خليفةً في الأرض عِبر تأريخ ( تكوينه ) وملابسات ذلك. وقد اتجه النص القرآني إلى صياغة هذه التجربة البشرية في شكل قصصي ؛ نظراً لأهمية ما يفرزه هذا الشكل من تعميقٍ في الاستجابة الفنية له.
من حيث عدد ( الأبطال ) نجد أنّهم منحصرون في ( أربع ) شخصيات فحسب، وهذا أدنى ما يتطّلبه ( الموقف ) من عدد: ( آدم، الملائكة، إبليس، حواء ). فآدم لا مناص من رسمه في القصة مادام الأمر متصلاً بكونه أباً للبشريّة، وحواء لا مناص من رسمها أيضاً بصفتها تجسيداً ( للاتحاد بين كائنين )، يتوقَّف عليهما استمرار التناسل البشري، أي: ( العائلة).
أمَّا ( الملائكة )، فكان رسمهم ضرورياً لا مناص منه أيضاً مادام الموقف مرتبطاً بأول تجربة على الأرض. كان الملائكةُ على إحاطةٍ تامة بما يستتبعها من ( صراع ) وسفك دم وغيرهما ؛ بصفة أنّ الملائكة عنصر واعٍ، لا يحيا الصراع بين الخير والشر، بعكس البشر الذين ركِّبوا من العقل والشهوة ( إنّ الله ركّب في الملائكة عقلاً بلا شهوة، وركبّ في البهائم شهوة بلا عقل، وركب في بني آدم كلتيهما )... الملائكة تفهم كل هذا، ولذلك تساءلوا عن السرّ الكامن وراء التجربة البشرية ( بخاصة إنَّ النصوص التفسيرية تذكر بأنّ ثَمَّة تجربة أرضية سابقة لعنصر ( الجان ) فيما واكبها سفك الدم والإفساد بعامة، فبعث الله الملائكة وأجلوهم عنها وجُعلوا مكانهم ).
طبيعياً هذا التفسير ينسجم تماماً مع المنطق الفنيّ للقصة، إلاَّ أنّ أهمية القصة القرآنية تتمثّل في كونها تُعلن عن منطقها الفنّي حتى لو ابتعدنا ( لغرضٍ فنيّ ) عن مناخ النصوص التفسيرية. فالملائكة - وهذا ما يُعلِن عنه المنطق الفنيّ في القصة - لا يمتلكون وعياً مطلقاً بالأمور، بقدر ما يمثّلون طبقة لا تحيا ( الشهوة ) ومتطلباتها من الصراع، وهذا ما أوضحته القصة ذاتها عند ما قالوا:( سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلّمْتَنَا... ) ، وعندما قال لهمُ الله ( تعالى ):( أَلَمْ أَقُلْ لّكُمْ إِنّي أَعْلَمُ غَيْبَ السّماواتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ) .
هذه الفقرات تقرِّر بوضوح أنّ الملائكة لا يعلمون كل شيء، وأنَّ الله ( تعالى ) منحهم جانباً من المعرفة، حتى إنّ آدمعليهالسلام علّمه الله الأسماء التي لم تعرفها الملائكة حينما طلب منها الله أن تخبره بها.
نستخلص من هذا أنَّ عنصر ( الملائكة ) كان لابدّ من رسمه في القصة: نظراً لعملية
السجود أولاً، وهي عملية ذات مغزىً ؛ لأهمية الكائن الآدمي الذي اسجد اللهُ الملائكة له، حتى يتعرّف دوره الخلافي الذي أؤكلَ إليه.
ثانياً: كشفَ وجودُهم عن حجم المعرفة التي يمتلكونها في هذا الصدد، وإلى أنَّ الله وحده يحتفظ بالمعرفة المطلقة.
ثالثاً: كان رسمهم مرتبطاً بأهم سمة تفرز الإنسان عن غيره في تجربة الأرض، حيث ارتبط وجودهم بأحد العناصر الذي ( استَزلَّ ) العنصر البشري، وترتَّب عليه الهبوط إلى الأرض.
ومن هنا نفهم ضرورة رسم الشخصية الرابعة في القصة، وهي: ( إبليس )، بصفته الطرف الآخر من تجربة الإنسان في تجاذبه بين العقل والشهوة، وبصفته الطرف الآخر من موقف الملائكة المتصل بعملية السجود.
إذن عدد الأبطال في القصة المذكورة، كان مرسوماً بنحوٍ تستهدفه القصة من تجربة الخلافة الأرضية وملابساتها.
أمّا من حيث تنوّع الأبطال ( بشراً وملائكة )، فإنَّ لهذا ( التنوّع ) ضرورته أيضاً مادام الأمر متصلاً بأبطال من غير البشر ( الملائكة، إبليس ) يُبلورون الموقف الذي سيترتَّب عليه المولد البشري بالنحو الذي أشرنا إليه.
وأمّا من حيث ( نموّ ) الأبطال و( تسطّحهم )١، أي التحوُّل والانقلاب الفكري في تصرّفاتهم، أو الثبات في ذلك، فأمرٌ نلحظ نمطه الأول في القصة، ولا نلحظ نمطه الآخر فيها. والسبب في ذلك يعود إلى أنّ ( التجربة ) بصفتها جديدة على كل الأبطال ؛ حينئذٍ فإنّ ( التحوُّل ) الفكري - سواء أكان بسيطاً مثل ( موقف الملائكة )، أو حاداً مثل موقف ( إبليس ) - يفرض ضرورته في هذا الصدد. والأمر نفسه فيما يتعلق بشخصيتي آدم وحواء في ( تحوّلهما ) المتمثّل في الاقتراب من الشجرة، حيث ترتّب على هذا ( التحوُّل ) الهبوط على الأرض كما هو واضح.
إنّ قصة آدمعليهالسلام ، أفرزت جملة من أبعاد الرسم للشخصية، من حيث: العدد والتنوّع والتحوّل.
وحين نتجه إلى قصة أخرى سنلحظ رسماً لسمات أخرى لدى الأبطال، يتعيّن ملاحظتها للتعرّف على الأهمية الفنية لرسم بهذا النحو أو ذاك.
قصة مؤمن آل فرعون:
في هذه القصة التي تُقدِّم بطلها على هذا النحو:
( وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبّيَ اللّهُ... ) .
إنَّ هذا البطل الذي تحدّثت عنه ( سورة المؤمن )، دخل إلى القصة بعد أن أنهى موسىعليهالسلام دوره في
القصة وهدّده فرعون بالقتل، حيث تدخّل لدى القوم لإنقاذ موسى من القتل، ولَعِبَ دوراً كبيراً في محاولة إصلاح القوم، بحيث جسّد حركة حيّة في القصة التي تنتظمها فصول متعددة لا يسمح المجال بعرضها الآن. لكننا نستهدف من الوقوف العابر عليها الإشارة إلى النمط الآخر من الشخصيات، التي يسمها طابع ( الثبات ) قبال سمة ( التحوُّل ) التي لحظناها في القصة السابقة.
طبيعياً لا تعني سمة ( التحوُّل ) مؤشراً إلى ما هو سلبي من السلوك، كما لا تعني سمة ( الثبات ) مؤشراً إلى ما هو إيجابي، بقدر ما تعني أنّ كلاً من ( البطلين ) يُرسمان بنحوٍ يحقّق الهدف الفكري من النص. ( فالتحوّل ) من الإيمان إلى الكفر سمة سلبية، و( الثبات ) على الكفر سمة سلبية، والعكس هو الصحيح أيضاً، ممّا يعني أنّ رسم ( التحوُّل ) أو ( الثبات ) يرتبط بأهداف فكرية مرصودة في القصة بنحوٍ فنيّ.
ولنعد إلى بطل القصة ( مؤمن آل فرعون):
لقد رسمته القصة ( رجلاً يكتم إيمانه )، وهذا يعني أنّ الشخصية ( مؤمنة ) أساساً، وعندما حان الوقت لأن تتخلّى عن مبدأ ( التقية )، توجّهت إلى الإعلان عن ( موقفها الفكري ) الثابت، وهو الجهاد في سوح الإصلاح وإنقاذ موسى، حيث انتهى رسمها في القصة وقد دفع الله عنها مكر القوم.
أنّ هذه الشخصية مارست نمطين من السلوك، أحدهما: التقية ( رجل يكتم إيمانه)، والآخر: الظهور عبر تدخّلها وإصلاحها فيما بعد... ومثل هذا ( التبدُّل ) في مظهر السلوك، لم يخرجها من دائرة ( الثبات ) إلى ( التحوُّل )، بل بقيت محتفظة بطابع ( الثبات )، وهو الإيمان طوال حياتها، كل ما في الأمر أنّها ( كتمت ) إيمانها حيناً، وأظهرته عندما استدعى السياق ذلك.
إنَّ هدفنا من الإشارة لهذا البطل أن نحدِّد معنى ( الثبات والتحوُّل ) من جانب، وأن نُبرز نمطاً للشخصية ( الثابتة ) من جانب آخر، وأن نُوضح المنطق الفني لمثل هذا الرسم من جانب ثالث. فنمط السلوك الذي يفرز مظهراً عن آخر لا يخرج البطل من سمة ( ثباته ) مادام المعيار هو: السمة الفكرية، وليس المظهر الاجتماعي. ففي الحالين ثَمَّة ( إيمان ) يفرض على الرجل حيناً أن ( يكتم ) ذلك، ويفرض عليه حيناً آخر أن ( يعلن ) عن ذلك. أمّا المسوّغ الفني لمثل هذا الرسم، فيتجسّد في إبراز كلٍ من مبدأ ( التقية ) و( الظهور ) كما لا يخفى، ممّا لا حاجة إلى إطالة الكلام فيه.
أمَّا رسم الشخصية ( ثابتة ) بنحو عام، فأمر تحدّده طبيعة الهدف في القصة، فحيناً يتطلّب الموقف إبراز شخصيات (ثابتة)، سواء أكانت إيجابية أم سلبية، لكي يفيد القارئ منها في تعديل سلوكه. وحيناً يتطلّب الموقف إبراز شخصيات ( متحولة ) للغرض نفسه.
مثال ذلك من الشخصيات ( المتحوّلة): السَّحَرَة الذين آمنوا في قصص موسى، وملكة
سبأ في قصة سليمان، حيث يفيد القارئ منهما في تعديل سلوكه عندما يقف على نهايات مثل هؤلاء الأبطال، الذين يجسّدون ( تحوّلاً ) إيجابياً.
مقابل ذلك نلحظ ( تحوُّلات ) إلى السلب، ومثاله ( إبليس ) في قصة آدم التي لحظناها، حيث يفيد القارئ منها في تعديل سلوكه أيضاً، من خلال التحوُّل المَشين الذي طرأ على شخصيته.
وأمَّا مثاله من الشخصيات ( الثابتة): الأنبياء بشكل عام، وشخصيات من أمثال: مؤمن آل فرعون، والرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى في قصة أصحاب القرية، وأبطال أهل الكهف وسواهم، حيث يفيد القارئ من ( ثبات ) شخصياتهم في تعديل سلوكه واحتذاء مواقفهم الثابتة في هذا الصدد.
مقابل ذلك نلحظ ( ثباتاً ) سلبياً في أشخاص آخرين، مثل: الأقوام البائدة في قصص نوح ولوط وصالح وشعيب... إلخ، ومثل: ابن نوح، أب إبراهيم، امرأة لوط، حيث يفيد القارئ منها في تعديل سلوكه عبر مشاهدته لمصائرهم الدنيوية.
كما نلحظ نمطاً ثالثاً من رسم الشخصيات التي تشّهد ( تحوّلاً ) في القصة، لكنَّه عند معاينة الموت أو حدوث الكارثة بهم، مثل: فرعون الذي أعلن عن إيمانه عند لحظات الغرق، ومثل صاحب الجنَّتين الذي قال:( يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً ) ... هذا النمط من الرسم أيضاً يساهم في تعديل السلوك عبر مشاهدة القارئ لمصائر شخصياته.
إذن كل أنماط الرسم للشخصيات المتحولة والثابتة، لها مساهمتها في تعديل السلوك الذي تستهدفه القصص أساساً.
وإذا تركنا كلاً من سمات الرسم المتصل بثبات الشخصية ونموها، وتنوّعها بين بشر وغيره، وتحددها في عدد خاص، واتجهنا إلى سائر أشكال الرسم القرآني للأبطال، واجهنا رسماً يتصل بتعريف الشخصية وتنكيرها، أو لنقل: إبهام الشخصية وتحديدها. فالملاحظ أنَّ بعض الشخصيات ترسمها القصة محددّة بالاسم والملمح الخارجي وغيرهما، في حين نجد أبطالاً آخرين ( يُبهمهم ) النص حتى في الاسم.
في قصة ( مؤمن آل فرعون ) نجد أنّ القصة ( أبهمت ) هذه الشخصية، وفي قصة أصحاب القرية نلحظ نفس السمة، ومثلها أبطال أهل الكهف، ومثلها شخصية النبي الإسرائيلي في قصة طالوت فيما لم تذكر حتى اسمه، وفي قصة القرية الخاوية التي وقف عليها أحد الأنبياء، وقال:( أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا... ) .
وفي قصة سليمان التي أبهمت الشخصية التي جلبت عرش بلقيس، ففي هذه القصص نلحظ شخصيات بمستوى النبوّة، وشخصيات بمستوى الأوصياء ( مثل الشخصية التي جلبت عرش بلقيس )، وشخصيات عادية. فمع هذا التفاوت بين الأبطال النبوِّيين إلى
الأبطال العاديين إلى الأبطال المتراوحين بينهما، نلحظ ( إبهاماً ) حيال شخصياتهم، في حين نلحظ تحديداً لأبطال سلبيين يحكمهم نفس الطابع، ولكنّهم محدّدون، مثل: فرعون وهامان وقارون وأبي لهب... وسواهم، هذا يعني أنّ كلاً من ( تعريف ) الشخصية و( تنكيرها ) له مساهمته الفنية التي يستدعيها مناخ القصة.
( الرسل ) على سبيل المثال طالما ( تُعرّف ) شخصياتهم، مثل: نوح وموسى وعيسى، مادام الأمر مرتبطاً برسالاتهم، ولكن حينما لا يتطلَّب الأمر ذلك، نجد - مثلاً - أنّ قصة طالوت تذكر حادثة الإسرائيليين مع ( نبيّ ) لهم، دون أن تعرّفنا ( باسمه ) مادام الأمر يتصل بوجود شخصية لها صلتها بالله في تهيئة القائد العسكري. هذا فضلاً عن أنَّها لم يكن تمحل طابع ( الرسول ). والأمر نفسه فيما يتصل بالشخصيات التي تمثّل ( الأوصياء ) فيما لم تكن ضرورة لتعريفهم، مثل: وصيّ سليمان الذي كان عنده علمٌ من الكتاب.
لكن عندما يتطلَّب الأمر ( تحديداً )، مثل شخصية هارون، نجد أنّ البطل المذكور ( يُعرّف ) باسمه ووظيفته أيضاً، بينا لم يُعرّف وصيّ سليمان لا بالاسم ولا بالوصاية ؛ لأنّ الأمر يتصل برسم شخصية تستطيع أن تملك ( معلومات ) أو ( قدرات ) لا يملكها حيناً حتى ( الأنبياء ) ؛ لإفهامِنا بأنّ ( الطاعة )، وليس ( الموقع الاجتماعي )، هي المعيار في السلوك.
إنَّ هارون كان لابدّ أنَّ ( يعرّف ) مثلاً ؛ مادام موسى أقل فصاحةً منه، حيث يتطلَّب الموقف ( كلاماً ) هو الحجة على فرعون وقومه. وكذلك فيما يتصل بمهمته عند ذهاب موسى إلى الجبل. والأمر نفسه فيما يتصل برُسل عيسى إلى أصحاب القرية، حيث أبهمهم النص ماداموا ليسوا أنبياء لهم رسالاتهم، بل مبعوثين من قِبلهم. وهكذا فيما يتصل ب- ( مؤمن آل فرعون )، حيث لا ضرورة لتحديد اسمه مادام مجرد شخصٍ يكتم إيمانه ويظهره في مناخ يستدعي ذلك، وحيث إنّ هدف القصة هو إبراز مفهوم كلٍ من التقية والإظهار، وليس إبراز هذه الشخصية أو تلك.
بعامة، أنَّ كلاً من التحديد والإبهام، أو التعريف والتنكير، له أهميته في ميدان رسم البطل في القصة، لارتباطه بالمفهومات التي يُستهدف التركيز عليها.
ولعل أهم أشكال الرسم للشخصيات، يتمثَّل في تقسيمها إلى ما هو ( رئيس ) وما هو ( ثانوي )، وإعطاء كل منهما دوراً خاصاً في تجسيد أفكار القصة، وهذا ما نقف عنده طويلاً عبر نموذج قصصي هو:
قصة يوسف:
تجسّد هذه القصة - بوضوح - أهمية كل من البطل ( الرئيس ) و( الثانوي). والمقصود بالبطل ( الرئيس ) هو الذي تحوم عليه حوادث القصة ومواقفها، بحيث لا يخلو دور منها. أمَّا
( الثانوي ) فهو الذي يمارس ( دوراً ) محدَّداً وتنتهي مهمته. والوظيفة الفنية للأبطال الثانويين هي: إلقاء الضوء على الشخصية الرئيسة، أو التجسيد لفكرة محدّدة يستهدفها القاص، أو إلقاء الإنارة على ( الهدف العام ) من القصة.
شخصية يوسف تجسّد ظاهرة الصبر على الشدائد، والاختبار، واجتياز ذلك أو التعثر فيه في بعض المواقف، وملافاة ذلك، وتمكينها من المُلك لهدف إصلاحي، هو: إنقاذ الجمهور من المجاعة.
أمَّا الأبطال الثانويون، فقد لعب كلٌ منهم دوراً مهماً في القصة.
شخصية ( يعقوب ) مثلاً، أبرزت واحداً من ( الدوافع )، هو: الأُبوة أو ( البنوة )، كما أبرزت مفهوم ( التفاضل ) بين الأبناء وانعكاس ذلك على سلوك الشخصية. وتتمثَّل عاطفة الأُبوة في تحذيره يوسف من قصّ الحلم على إخوته، وفي إيصاء إخوته على المحافظة عليه من الذئب، وفي إيصائهم بالدخول من أبواب متفرقة، وفي عاطفته حيال إلخ الأصغر عند ذهاب الإخوة لجلب الطعام... وتتضخّم هذه العاطفة بنحو تنعكس على استجابة يعقوب حيال يوسف بحيث ابيضّت عيناه من الحزن.
أمثلة هذه العاطفة وتضخُّمها، لها أهميتها الكبيرة في ميدان التربية وعلم النفس وانعكاساتها في السلوك. كما أنّ ( التفاضل) بين الأبناء له انعكاساته على الأطفال والراشدين، فيما جسّدت القصة كلّ هذه المفهومات بطريقة فنّية ممّتعة كل الإمتاع. هذا إلى أنّ كلاً من ( الصبر ) و( التوكل ) على الله في دفع الشدائد، كان إفرازاً واضحاً لشخصية يعقوب، بحيث ترتّب على ذلك عودة يوسف وارتداد الأب بصيراً.
أمَّا إخوة يوسف، فقد جسّدوا مفهوم ( الغيرة ) الناجمة من التفاضل، أو مفهوم ( الحسد ) الناجم منه، بحيث ترتّب على ذلك أن يصوغوا مؤامرة ضخمة حيال يوسف على النحو المأساوي الذي سردته القصة. بَيْد أنَّ مفهوم ( التفاضل ) المذكور لا يترك انعكاساته التي لا سبيل إلى تعديلها، بل نستخلص من القصة أنّ ( التفاضل ) له جانبه السلبي في صياغة السلوك، ولكن ليس على النحو الذي لا سبيل إلى تعديله: حيث تاب الإخوة وأدركوا خطأ سلوكهم وعدّلوا سلوكهم في نهاية المطاف.
أمَّا امرأة العزيز، فقد جسّدت أحد الدوافع الملحّة عند الآدميين وبخاصة الأُنثى، ونعني به ( الدافع الجنسي )، لكن القصة أبرزت في الآن ذاته إمكانية السيطرة عليه والاستعانة بالله في ذلك. يقابله: عدم السيطرة في حالة انعدام الوعي العبادي لدى ( الشخصية ) - وهو ما طبع شخصية امرأة العزيز - فضلاً عن استتلائه التورُّط في صياغة ( جرائم ) ضخمة في حالة الإحباط، وبخاصة لدى ( الأنثى ) التي تتحوّل إلى ( أفعى ) بمجرد غضبها على الرجل: حيث لم تتورّع من اتهام يوسف وسجنه. ولكن يظل السلوك قابلاً للتعديل، وهذا ما تحقّق فعلاً من
خلال توبتها وإقرارها بنظافة يوسف.
( نسوة المدينة ) بدورهن جسّدن مفهوم ( الغيرة ) من النساء، حيث انطلقن من دافع ( الحسد ) و( الغيرة ) في تشهيرهنّ بامرأة العزيز، وليس بدافع من الفضيلة. ولذلك سرعان ما قطّعن أيديهن عند مرور يوسف عليهن... وهذا كلُّه فيما يتصل بتجسيد الأفكار المطروحة في السورة.
أمَّا من حيث إلقاء الضوء على شخصية يوسف، وتأثير الأبطال الثانويين في مسار الأحداث، فأمر لا يحتاج إلى توضيح أنّ لكل من الشخصيات المذكورة مساهمتها: فصاحبا السجن كشفا عن المقدرة العلمية عند يوسف في تفسيره للأحلام، وإخوته كشفوا عن عنصر التسامح لديه، وامرأة العزيز كشفت عن نظافته... وهكذا.
إذن الأبطال الثانويّون لعبوا أدواراً ضخمة في القصة، من حيث تجسيدها لمختلف الأفكار والمفهومات المتصلة بتركيبة الإنسان وسلوكه، من جنس وحسدٍ، وغيرة وتسامح ونقاء، وتعديل سلوك، وتوكّل على الله، وصبر على الشدائد... إلخ.
عنصر الحوار في القصة:
الحوار - كما نعرف جميعاً - هو: حديث البطل مع غيره، وحديثه مع نفسه. ومن البيّن أنّ هذا العنصر يجسّم حيوية القصة بأعلى درجاتها ؛ مادام ( الكلام ) مع الغير أو مع النفس هو المفصِح عن دوافع الشخصية ورغباتها، عن صراعها وهدوئها، بل إنّ ( الكلام ) قد يحسم مصير الفرد أو الجمهور أو الأُمة.
وبالرغم من أنّ ( السرد ) الذي يعني ( قص ) الأحداث والمواقف ونقلها إلى الآخرين، بمقدوره أن يكشف عن أعماق الشخصية، إلاَّ أنَّه لا تتوفّر فيه إمكانات الحوار ؛ لجملة من الأسباب، منها: أنّ ترك الشخص يتحدّث بنفسه يظل أشدّ حيوية من نقل كلامه. كما أنّ ما لديه من ( أفكار ) لا يستطيع المُلاحِظ تعرّفها ما لم يعلِن الشخص ذلك بنفسه، فضلاً عن أنّ بعض ( الأسرار ) لا يمكن التحدّث عنها حتى بلسان البطل، بل يظل متحدّثاً بها مع نفسه، وهذا ما يتطلّبه أحد شكلَي الحوار، ونعني ( الحوار الداخلي).
كما أنّ هناك ( حالات ) خاصة يستدعيها ( التداعي الذهني )، الذي ينتقل من خلالها الذهنُ من موضوعٍ لآخر تربطه به علاقات ( التشابه )، أو علاقات لا شعورية يتداعى الذهن إليها دون أن ينتبه الشخص إلى مغزى ذلك. ولذلك نجد أنّ القصة الحديثة تلجأ في كثير من نماذجها إلى ترك البطل ( يُداعي ) بذهنه إلى موضوعات لا علاقة ظاهرية بينها، فيما يستثمر القاص هذه الخصيصة لطرح مختلف ( الأفكار ) التي يستهدفها.
المهم، أنّ ( القصة القرآنية ) تعتمد عنصر ( الحوار ) بأشكاله المتنوّعة التي يستدعيها هذا الموقف أو ذاك: مع ملاحظة أنّ الفارق بين القصة الأرضية وقصص القرآن يتحدّد - بوضوح -
من حيث معرفة ( المبدع ) بما في الصدور وامتناع ذلك عند القاص البشري ؛ الأمر الذي يجعل لعنصر ( السرد ) في كشفه عن الأعماق نفس ( الفاعلية ) الموجودة في ( الحوار). بَيْد أنّ القصة القرآنية - على الرغم من ذلك - تدع البطل يتحدّث مع غيره، أو مع نفسه: بغية توفير عنصر ( الإقناع ) من جانب، وتحقيق المتعة الفنية التي يتطلّبها شكل القصة من جانب آخر.
وسلفاً، ينبغي أن نوضح بأنّ ( الحوار ) القرآني يتخذ - كما قلنا - أشكالاً متنوّعة، بعضها متوفرٌ في القصة الأرضية وبعضها الآخر غير متوفر فيها. فهناك الحوار الخارجي متمثّلاً في محادثة الشخص مع آخر أو مع مجموعة، وهناك الحوار الجمعي المبهم، وهنالك الحوار المحدّد. فضلاً عن ( حوار ) خاص مع ( الله )، وحوار مع ( النفس )، ومجرد ( تفكير ) يأخذ سمة الحوار، وفضلاً عن ( الحوار ) مع الأجناس غير البشرية... إلخ.
المهم أنّ ( الموقف ) هو الذي يحدّد نمط ( الحوار ) الذي تستخدمه القصة القرآنية. ونبدأ بالحديث عن:
الحوار الداخلي:
قلنا إنّ هناك حالات تتطلّب من البطل أن يتحدّث فيها مع نفسه، وهذا الحديث قد يكون مجرد ( تفكير )، أو حديثاً بالفعل، لكنّه موجّه إلى الداخل، ولكلٍ منهما - كما هو واضح - متطلّباته النفسية. ولنأخذ نموذجاً على ذلك:
قصة الأبرار:
هذه القصة التي تنقلها سورة ( الدهر ) تتحدّث عن ( بيئة الجنة )، وهي تمثّل نموذجاً لقصص البيئة التي سنتحدث عنها لاحقاً، لكن يعنينا منها هذا الحوار المسبوق بالسرد:( إِنّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً * عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّهِ يُفَجّرُونَهَا تَفْجِيراً * يُوفُونَ بِالنّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرّهُ مُسْتَطِيراً * وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلَى حُبّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً * إِنّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّهِ لاَ نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُوراً * إِنّا نَخَافُ مِن رَبّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً * فَوَقَاهُمُ اللّهُ شَرّ ذلِكَ الْيَوْمِ... ) .
القصة تتحدّث عن ( الجنّة ) وموقع ( الأبرار ) فيها، وبطريقة فنية في التعامل مع الزمن تنتقل من بيئة ( الجنة ) إلى بيئة (الدنيا )، فتنقل عن الأبطال بأنّهم كانوا يوفون بالنذر ويخافون الحساب ويطعمون الطعام لوجه الله. ثمَّ تقطع القصة عنصر (السرد ) وتدع الأبطال بأنفسهم يتحدّثون عن حقيقة سلوكهم الذي استحقوا عليه الموقع المذكور من الجنة، وهاهم الأبطال (يفكرون ) بهذا النحو:
( إِنّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّهِ لاَ نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُوراً * إِنّا نَخَافُ مِن رَبّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً ) .
إنّ هؤلاء الأبطال عندما قدّموا طعامهم إلى الفقراء لم يقولوا لهم: إنّما نطعمكم
لوجه الله... إلخ، كما أنّهم لم يتحدّثوا بذلك فيما بينهم، بل لم يصوغوا ذلك ( كلاماً خفياً ) مع أنفسهم، بل كان ذلك مجرد ( تفكير ) يحيونه داخل أنفسهم، أي أنَّه كان ( نواياً ) لا أكثر، بحيث يُشبه تقديمك مساعدةً لأحد الأشخاص وأنت منفعلٌ بحالته الاقتصادية، دون أن ينطق لسانك بكلمة، ودون أن توجّه كلاماً خفياً إلى أعماقك. إنَّه يشبه الحقيقة التي يقرّرها بعض علماء النفس من أنّ ( التفكير ) هو ( كلام غير منطوق )، أي أنّك عندما تفكّر في شيءٍ ما، إنّما ( تتكلّم ) دون أن تستخدم أجهزة النطق... ويمكننا أن نطلق عليه اسم ( الحوار التفكيري ) أو ( الحوار الذهني). وأهمية مثل هذا الحوار في القصة المذكورة تتمثَّل في لفتها الانتباه إلى ضرورة أن يتم العمل لوجه الله. ولكي تجسّد القصة هذا الهدف ؛ اتجهت إلى إبراز ذلك من خلال ( التفكير بالشيء )، أي: بنوايا الشخصية التي لا مناص من إبرازها في ( حروفٍ مكتوبة ) ؛ لكي يتعرّفها القارئ ويفيد منها في تعديل سلوكه.
إنّ النمط المتقدم من ( الحوار الداخلي ) يشكّل مجرد ( نوايا ) في ذهن البطل، وهناك نمط من ( الحوار الداخلي ) يجسّد (كلاماً موجهاً إلى داخل النفس )، وهذا ما يمكن ملاحظته في قصة ( صاحب الجنتين )، الذي قال بعد أن أُبيدت مزرعته:( وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبّي أَحَداً ) ، حيث قلب أكفّه وخاطب نفسه قائلاً:( يَا لَيْتَنِي... ) . ومثله الكلام الذي وجهه ( هابيل ) إلى نفسه عندما أراد أن يواري أخاه:( قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ... ) .
ففي هذين النموذجين ( كلام ) خفيّ يوجِّهه الشخص إلى نفسه، ولم يكن مجرد ( تفكير ) أو ( نوايا ) أو عمليات ذهنية أخرى.
الحوار المزدوج:
هناك نمط من الحوار الحيّ يتمثّل في: التحاور مع الله، ومع الآخرين، في مسارٍ واحد من العرض القصصي. وأهمية هذا الحوار تتمثَّل في وقوفنا على طريقة البطل في أداء وظيفته التي أوكلتها السماء إليه، بحيث يفيد القارئ منها في طريقة تعامله مع الآخرين عبر أداء مهمَّته العبادية. وأوضح مثل لذلك هو:
قصة نوح:
في سورة نوح تبدأ القصة بهذا السرد أولاً:
( إِنّا أَرْسَلْنَا نُوحاً إلى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) .
بعد هذا السرد يبدأ ( الحوار):
( قَالَ يَاقَوْمِ إِنّي لَكُمْ نَذِيرٌ مّبِينٌ * أَنِ اعْبُدُوْ
اللّهَ وَاتّقُوهُ وَأَطِيعُونِ * يَغْفِرْ... ) .
فهذا الحوار ( خارجيٌ ) يوجّه نوحٌ من خلاله الكلامَ إلى قومه.
لكنَّه بعد ذلك يتّجه نوح بكلامه إلى الله ( تعالى ):
( قَالَ رَبّ إِنّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَاراً * فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلاَّ فِرَاراً * وَإِنّي كُلّمَا... ) ،( ثمَّ إِنّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَاراً * فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا... ) ،( وَقَالُوا لاَ تَذَرُنّ آلِهَتَكُمْ ) ،( وَقَالَ نُوحٌ رّبّ لاَ تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ... ) .
فالمُلاحَظ هنا أنَّ نوحاً ينقل إلى الله كلامه مع قومه، والنص القرآني ينقل لنا كلام نوحٍ مع الله. فنوح هنا ( قاص ) ينقل للسماء قصصه مع قومه، والنص القرآني بدوره ( قاص ) يعرض لنا قصص نوحٍ للسماء... وهكذا.
إذن، نحن حيال هيكل من ( الحوار ) له تفرّده وحيويته الفنية، حينما يدعنا - نحن القرَّاء - نقف على طريقة نوح في أداء الرسالة وبلسانِه نفسه: حيث يتحدّث مباشرة عن ذلك: مع الله، لا أنّ النص هو الذي ينقل ( الكلام).
الحوار الجمعي، والداخلي:
هناك نمط من الحوار الذي تطبعه سمة ( الجماعة ) التي تتحدّث فيما بينها، دون أن يصاحبه ( ردّ )، أي: أنَّه مجرد ( حديث )، يتعاون المجموع في نقله داخل التجمّع، لا أنَّه حديث مع الآخرين، وردّ عليه، بل هو حوار أُحادي الجانب: كما لو كان هناك مجلس يتحدَّث فيه جماعة عن قضية معينة... وهذا النمط من الحوار له جماليته الفائقة أيضاً ؛ من حيث كونه يجسّد حيويّة المجلس الذي يتحاور القوم فيه، أي أنَّه ينقل لنا صورة واقعية عن كلام قوم، وكأن القارئ حاضرٌ داخل مجلسهم يستمع إلى وقائع هذا المجلس. وأوضح نموذج لهذا النمط في الحوار الحي هو:
قصة الجن:
في سورة الجن، تواجهنا قصة تعتمد ( الحوار ) الخالص شكلاً قصصياً لها، دون أن يتخلّلها أي سرد عدا نهاية القصة، وهذا واحدٌ من أنماط البناء القصصي الذي يجسّد الشكل الثالث منه، أي القصة التي تعتمد الحوار وحده، مقابل ما تعتمد السرد لوحده، وما تعتمد كلاً منهما.
المهم أنّ القصة تبدأ بهذا النحو:
( إِنّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجباً... ) ،( وَأَنّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً * وَأَنّهُمْ ظَنّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَن يَبْعَثَ اللّهُ أَحَداً * وَأَنّا لَمَسْنَا السّماءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً * وَأَنّا كُنّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَصَداً * وَأَنّا لاَ نَدْرِي أَشَرّ أُرِيدَ بِمِن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبّهُمْ رَشَداً... ) .
إنّ هذا النمط من ( الحوار ) يبدو وكأنَّ البطل هو نفسه ( قاص )، يسرد لنا ( بضمير المتكلم ) تفاصيل العمليات الفكرية التي يحياها. وأهمية مثل هذا الحوار - كما قلنا - أنَّها تضعنا وجهاً لوجه
أمام وقائع المجلس الذي اجتمع فيه القوم، أو أمام قاص يسرد لنا قصته من خلال الحوار الداخلي.
لقد كشف هذا الحوار عن ( أحداث ) و( مواقف ) واجهها أبطال الجن فيما يتصل برسالة الإسلام، بما صاحَبها من تغيير في سنن الكون، ومنها: عدم السماح بهذا العنصر ( الجان ) من الصعود إلى السماء والاستماع إلى الملائكة ومشاهدة الشهب، بعد أن كانت لهم حرية التنقّل قبل ذلك.
ولا يخفى على القارئ أهمية مثل هذا الحوار الذي كشف عن وقائع خطيرة في الظاهرة الكونية، واستخلاصه أهمية الرسالة الإسلامية في هذا الصدد، ليس من خلال تقريرٍ عملي، بل من خلال لغة فنّية يحدِّثنا أبطال الجن بأنفسهم عن الوقائع المذكورة.
القارئ مدعوّ للمرة الجديدة أن يتابع حيوية مثل هذا الحوار الجماعي، وأهميته في نقل الحقائق الخطيرة من خلال لغة مُمتعة يحياها القارئ وكأنَّه واحد من الحاضرين.
الحوار المسرحي:
هناك نمط من ( الحوار ) القصصي المتميّز بكونه ( أُحادي الجانب ) أيضاً، لكنَّه لا يتحدَّد في ( مجلس ) خاص يضم الأبطال، بل يتم في ساحات متعددة، كل ساحة منها تضم أبطالاً يتحاورون فيما بينهم، أو يحاضر فيها أحد الأبطال أمام الجمهور. وأهمية هذا الحوار تتمثَّل أيضاً في كونها تدع القارئ وكأنَّه ( مُشاهد ) يقف على تحرُّكات الأبطال، ويستمع إلى مقرّراتهم وخطاباتهم أمام الجمهور. وأوضح نموذج لهذا الحوار هو:
قصة مؤمن آل فرعون:
في هذه القصة التي سبق التلميح إليها، يتدخّل بطل آل فرعون لإنقاذ موسىعليهالسلام بعد أن اقترح فرعون قتله، ويتقدّم بنصائحه إلى القوم لحملهم على الإيمان بالله... لقد بدأت القصة بهذا النحو:
( قَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبّيَ اللّهُ... يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا ) ،( قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى... ) ،( وَقَالَ الّذِي آمَنَ يَاقَوْمِ إِنّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ... ) ،( وَقَالَ فِرْعَونُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً... ) ،( وَقَالَ الّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتّبِعُونِ... ) .
فالملاحظ هنا أنّ القصة عرضت لنا مؤمن آل فرعون: وقد تكلّم مرتين، وعرضت لنا فرعون: وقد تكلّم مرتين أيضاً... إلاَّ أنّ كلام كلٍ منهما غير موجّهٍ إلى الآخر، بل إلى الجمهور، حيث لا نجد في بعض الفقرات ( علاقة ) بين كلامي كلٍ منهما. ويمكننا أن نتصور الموقف على هذا النحو: هناك قاعة أعدّت لعقد اجتماع يحضره فرعون وهامان وكبار الموظَّفين، وربَّما جماعة من
الجمهور أيضاً. مؤمن آل فرعون يحضر بدوره هذا الاجتماع بصفته أحد كبار موظَّفي الدولة. فرعون يفتتح الاجتماع مقترحاً على الحاضرين قتل موسىعليهالسلام . ويتدخّل هنا مؤمن آل فرعون مدلياً برأيه في هذا الصدد مشيراً إليهم بعدم قتله. لكنَّ فرعون يقاطعه مبيّناً أنّ الصواب هو قتل موسى.
وهنا يعود المؤمن إلى الكلام ثانية، ولكنّه يوجّه كلامه إلى الحاضرين، مذكّراً إيّاهم بحوادث القرون الغابرة.. ويكفّ عن الكلام. ويعود فرعون من جديد متحدّثاً مع الحاضرين - لا مع البطل - وكأنَّه يريد التعريض بشخصية المؤمن وتخطئته، أو السخرية منه، ونقل الحديث إلى وجهة أخرى، فيخاطب وزيره هامان قائلاً:( ابْنِ لِي صَرْحاً... ) . لكن المؤمن - وهو يدرك سخف الحديث الذي شغل به فرعونُ أذهان الحاضرين - يقاطع كلامه قائلاً للقوم:( اتَّبِعُونِ... ) ، ثمَّ يستمر في كلامه... ثمَّ ينفض الاجتماع بعد أن يختم المؤمن كلامه بالحديث عن اليوم الآخر ويذكِّرهم بأنَّهم سوف يندمون على ذلك.
إنَّ القارئ - من خلال الحوار المتقدِّم - يقف، مثلما قلنا، وكأنَّه ( مشاهِد ) على ( مسرح ) الأحداث، يتعرّف وجوه الأبطال وجمهورهم ومحاوراتهم وتعاملهم مع الأبطال الآخرين ومع الجمهور.
ومثلما قلنا فإنَّ هذا النمط من ( الحوار المسرحي ) له فاعليّته الكبيرة في إمتاع القارئ وشدّه إلى مشاهدة مسرح الأحداث مباشرة، كاشفاً بنفسه عقلية فرعون وحاشيته بما يواكبها من سخف وسخرية، مقابل ما يلحظه عند ( مؤمن آل فرعون ) من جدّية وتحرّق ومحبّة للقوم عبر نصائحه وتحذيره.
الحوار الغيبي:
نقصد ( بالحوار الغيبي): التحاور مع ( الله ) تعالى. وهو يأخذ نمطين من الرسم: أحدهما: بين الله والعبد من خلال ( الطلب والإجابة )، والآخر: ( انفرادي ). وهو على نمطين أيضاً: فقد يكون ( أمراً ) من الله، أو يكون ( دعاءً ) من العبد. ولكل من الأنماط الثلاثة أهميتها الفنية في القصة.
من النمط الأول الحوار التالي بين الله وموسى ( في سورة طه ):
قصة موسى:
( وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى * قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكّؤُا عَلَيْهَا وَأَهُشّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى * قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى * فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيّةٌ تَسْعَى * قَالَ خُذْهَا وَلاَ تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى * وَاضْمُمْ يَدَكَ إلى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى * لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرى * اذْهَبْ إلى فِرْعَوْنَ إنَّه طَغَى *
قَالَ رَبّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَيَسّرْ لِي أَمْرِي * وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي * وَاجْعَل لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي * هَارُونَ أَخِي * اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي... ) .
طبيعياً كان من الممكن أن تتحدَّث القصة عن موسىعليهالسلام على نحو السرد، كأنّ تقول: لقد أوحينا إلى موسى بالذهاب إلى فرعون، ومعه آيتا العصا واليد... إلخ. بَيْد أنّ ( الحوار ) هنا ينطوي على وظائف فنية في غاية الخطورة: ليس من حيث الإمتاع الجمالي فحسب، بل من حيث إبراز طريقة التعامل بين الله والعبد من جانب، وإبراز مختلف الاستجابات البشرية التي لا يمكن أن نتعرّف دقائقها إِلاَّ من خلال ملاحظتنا لتصرفات البطل نفسه.
فمثلاً، بالرغم من أنَّ موسىعليهالسلام يتحدّث مع الله، إِلاَّ أنّ ( الخوف ) من الحيّة سيطر عليه. ترى هل تُريد القصة أن تقول لنا: إنّ الخوف من ( الأخطار الطبيعية ) أمرٌ في الصميم من تركيبة الآدميين ؟ من الموكَّد أنَّ ( الخوف ) كذلك، ولكن هل يعني ذلك أيضاً أنّ الانفعال المذكور يبقى محتفظاً بفاعليته حتى لو تعامل صاحبه من الله ؟ قد يكون ذلك أيضاً صحيحاً ما دامت رواسب التجربة الطبيعية كامنة في الإنسان.
بَيْد أنَّه من الممكن أيضاً أن نستخلص من أنَّ مثل هذه التجربة الانفعالية في الخوف، ستكون مركز انطلاق لإزالة الخوف في وقائع لاحقة... ولكن حتى الوقائع اللاحقة أثبتت أنَّ موسىعليهالسلام قد خامره ( الخوف )، ولكن ليس من مخاطر طبيعية، بل من سيطرة كيد العدو، وهذا ما فسّرته النصوص الواردة عن أهل البيتعليهمالسلام من أنَّه لم يخف إلاَّ من أجل ما قلنا:( لا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى ) . هذا النمط من ( الخوف ) - أيضاً - كشفه ( الحوار ) بنحو أوضح مشاعر موسى.
وبالرغم من أنّ موسى لم يعلن عن خوفه ب- ( كلام )، وأنَّ ( السرد ) هو الذي أوضح ذلك، بَيْد أنَّ ( الكلام ) الموجّه من ( الله ) إلى موسى هو الذي تكفّل بتوضيح العملية المذكورة، وهو نمط لا يُقرر ( الخوف ) من خلال مجرد ( السرد )، بل من خلال طرف آخر من ( الحوار ) هو الله تعالى، بحيث نستكشف من توجيه الكلام إليه انفعاله المذكور... وهذا نمط آخر من وظائف الحوار الكاشف عن أعماق الشخصية من خلال طرف مُحاور آخر.
وأيَّاً كان فإنَّ هدفنا من تقديم هذا النمط من الحوار، أن نوضح مستوياته المختلفة في الكشف عن أعماق الشخصية، فضلاً عن أنَّ أمثلة ( الخوف ) المتقدم تظل - في تصورنا - منطلقاً لتجارب لاحقة تتكرّر أيضاً، حيث نلحظ في قسم آخر من القصة ذاتها ما يلي:( وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى * قَالَ هُمْ أُولاَءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبّ لِتَرْضَى ) ، فهذا التعجّل بدوره نمطٌ من ( الخوف)، ولكن من الله: من حيث تعطُّشه لرضى الله.
إذن ثلاثة أنماط من ( الخوف ) كشفها ( الحوار ) الحيّ في هذه القصة الطويلة الممتعة ذات الفصول المتعددة: بعضها يتصل بمخاطر طبيعية، والآخر بكيد العدو، والثالث بالخوف
من الله... إلاَّ أنَّها جميعاً ( عُوتِبَ ) عليها موسىعليهالسلام ، وهذه الأنماط من التّعرف على ظاهرة ( الخوف ) ليست أمراً سهلاً، بقدر ما تتطلّب تركيزاً من القارئ لمعرفة ما إذا كانت أمثلة الخوف المتقدّم أمراً طبيعياً لا غبار عليه: كل ما في الأمر أن القضية تتطلّب ( تدخلاً ) من الله في دفع البطل إلى الأمام. وهذا مِن نحو مَن يحرص على رضى الله ويتألّم من مشاهدته لمفارقات الآدميين، بَيْد أنّ الله يقول له: لا تهلك نفسك أسىً على الظالمين، بمعنى أنَّ الشخصية صدرت عن سلوك طبيعي، وأنَّ الله يوجّهه إلى ممارسة تحرك آخر، لا أنَّ السلوك ( خطأ ) في طبيعته... والفارق كبير بين التصوّرين.
على أيَّة حال، إنَّ ( الحوار ) تكفّل بإبراز أمثلة هذه الاستجابات التي لحظناها عند موسى، وإمكان إفادتنا من التعرّف عليها في صياغة سلوكنا العبادي. والأَهم من ذلك أنَّ ( الحوار ) مع ( الله ) - وليس الحوار بين الآدميين أنفسهم - هو الذي تكفّل بتحديد الظواهر التي وقفنا عليها، بصفة أنَّ التحاور مع ( الله ) يحسم الأمور، ويقطع على القارئ أي تشكيكٍ في استكناه حقائق الأمور.
وأمَّا القسم الآخر من ( الحوار )، بنمطيه: الانفرادي الذي يوجِّهه الله إلى العبد، أو العبد في توجِّهه نحو الله... هذا القسم من الحوار تتطلّبه مواقف معينة لا حاجة فيها إلى ( تبادل ) الكلام بقدر ما يتطلّب الموقف إجابة الطلب أو توجيه الأمر، وهذا مثل قصة ذي النون في طلبه من الله تخليصه من الغم:( فَنَادَى فِي الظّلُمَاتِ أَن لاّ إِلهَ إِلّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ الظّالِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ) ، حيث اكتفى النص ب- ( السرد )، وهو ( استجبنا )، بدلاً من مخاطبة ذي النون... وهذا فيما يتصل بتوجه العبد إلى الله.
أمَّا فيما يتَّصل بالأمر من الله إلى العبد، فمثاله قصة إبراهيم مع ولده في قضية الذبح، حيث وجّه الله ( الكلام ) إلى إبراهيم:( وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدّقْتَ الرّؤْيَا... ) حيث تمت الحكاية دون أن تتطلّب ( جواباً ) من إبراهيم.
وواضح أنَّ ذا النون طلب من الله تخليصه من الغم، فيما لا حاجة إلى توجيه الرد عليه بقدر ما يتحقق الأمر في(الاستجابة) ؛ ولذلك تكفّل السرد بهذا الأمر( فَاسْتَجَبْنَا ) ، كما أنَّ إبراهيمعليهالسلام عندما طلب منه الله أن يكفّ عن الذبح، امتثل الأمر دون أن تكون ثمَّة حاجة إلى الكلام.
إذن: في ( الحوار الغيبي ) بأشكاله الثلاثة، لحظنا المسوّغات الفنية لصياغتها بذلك النحو الذي يتميّز عن أشكال الحوار الأخرى التي وقفنا عليها سابقاً.
وهناك شكل ( حواري ) يتصل بهذا الجانب، وهو:
الحوار الملائكي:
وهذا يتم بين طرف ملائكي وطرف آدمي، مثل: محاورة الملائكة لزكريَّا:
( فَنَادَتْهُ
الْمَلاَئِكَةُ... أَنّ اللّهَ يُبَشّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدّقاً ) ، ومثل محاورتهم مع مريم:( وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنّ اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ) .
وواضح أنَّ ( المَلَك ) مجرد ( رسول ) بين الله والشخصية، بَيْد أنَّ ( الجواب ) يجيء مع ( الله ) وليس مع الملك ؛ ولذلك هتف زكرياعليهالسلام :( رَبّ أَنّى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ ) ، وهتفت مريمعليهالسلام :( رَبّ أَنّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ... ) .
وقد يتم حوار مباشر مع رسل السماء، مثل محاورتهم مع إبراهيم حيال تبشيره بولدٍ، ومهمّتهم بالنسبة لقوم لوط:( إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلاَماً قَالَ إِنّا مِنكُمْ وَجِلُونَ * قَالُوا لاَ تَوْجَلْ إِنّا نُبَشّرُكَ بِغُلاَمٍ عَلِيمٍ ) ، ومحاورتهم للوطعليهالسلام :( قَالَ إِنّكُمْ قَومٌ مّنكَرُونَ * قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ) .
وهناك حوار مع عضويّة أخرى، مثل: الطائر والنمل فيما يتصل بقصة سليمان كما نعرف ذلك جميعاً.
وأخيراً هناك:
الحوار المألوف:
ونعني به: الحوار الخارجي بين الأبطال، فيما لا حاجة إلى الوقوف عنده مادام الغالب من النصوص قائماً على الشكل المذكور، حيث وقفنا على نماذج منه في قصص طالوت وإبراهيم وموسى وغيرها، لحظنا من خلالها - وسائر أشكال الحوار أيضاً - مساهمة الحوار في تطوير الأحداث وإنارة الأبطال، بما يصاحبه من حيوية وإمتاع تجعلان القارئ على تشوّقٍ أشدّ في تلقيّه للنص ؛ من حيث وقوفه مباشرةً على تحركّهم في القصة.
قصص البيئة:
نقصد بقصص ( البيئة ) ذلك النمط من القصص التي يطغى فيها عنصر ( البيئة ) بالقياس إلى عناصر الأبطال والحوادث والمواقف. وأهمية هذا الفرز بين العنصر الغالب على القصة ؛ تتمثّل في إسهام كل عنصر في تحقيق ( استجابة ) محدّدة لدى القارئ، بحيث تسحب على ذهنه انطباعاً مركَّزاً يفيد منه في تعديل السلوك.
وعنصر ( البيئة ) يجيء حيناً في رسم التجارب الدنيوية، وحيناً آخر ينتقل إلى الحياة الآخرة: القبر، الموقف، النار، الجنة... ومثاله من البيئة الدنيوية قصة صاحب الجنَّتين التي وقفنا عليها، وقصة أصحاب المزرعة التي أُبيدت غداة حلفَ أصحابها على أن يقطعوا أثمارها دون أن يصلوا ذلك بمشيئة الله ( وردت الأقصوصة في سورة القلم ).
وواضح أنّ هاتين
الأقصوصتين تحومان على ( بيئة جغرافية). وهناك قصص تحوم على بيئات أخرى، مثل: قصص داود وسليمان وذي القرنين في رسمها لبيئات ( صناعية ) تتصل بالحديد والتماثيل والسد ونحوها.
المهمّ أنّ رسم أمثلة هذه البيئات، فضلاً عن إمتاعها الجمالي المتصل بالدافع إلى الاستطلاع، تظل ذات هدف فكري يصل بين ( نِعَم ) الله والشكر عليها، وضرورة استثمارها في العمل العبادي. أمّا رسم ( البيئات الأُخروية )، فإنّ استثمار دلالاتها يظل في الصميم من اهتمامات القارئ ؛ التي سيفيد منها في تعديل سلوكه ومتابعة ( الأحسن من العمل ).
ويحسن بنا أن نختم هذا الحقل المتصل بالعنصر القصصي القرآني، بنموذج من قصص ( البيئة ) المتمثِّلة في ( الجنَّة )، وهي قصة ( الجنان الأربع ) التي وردت في سورة ( الرحمان).
في هذه القصة سردٌ يصف أربع جنّات على نحو مزدوج، أي: جنتين لبطل، وجنّتين لآخر.
تقول القصة:
( وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَنّتَانِ... ذَوَاتَا أَفْنَانٍ... فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ... فِيهِمَا مِن كُلّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ... مُتّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنّتَيْنِ دَانٍ... فِيهِنّ قَاصِرَاتُ الطّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانّ... كَأَنّهُنّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ... هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلّا الْإِحْسَانُ ) .
وتقول القصة عن الجنتين الأخريين:
( وَمِن دُونِهِمَا جَنّتَانِ... مُدْهَامّتَانِ... فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضّاخَتَانِ... فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمّانٌ... فِيهِنّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ... حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ... لَمْ يَطْمِثْهُنّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانّ... مُتّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيّ حِسَانٍ ) .
السؤال هو: هل أنّ كلاً من الجنتين رُسِمَ بطبقة واحدة من الأبطال، أم رُسِمَ لطبقتين: عليا ودنيا ؟ الذي نميل إِليه هو أنّ كلاً منهما مرسومٌ على نحو التفاضل.
وأهمية هذا السؤال والإجابة عليه له انعكاساته على أهمية الوظيفة العبادية للإنسان، وانسحابها على ( الموقع ) الذي يحتلّه ( مؤمنون ) من طبقة عليا، و( مؤمنون ) أقل درجة من الأُولى.
إنّ ( الهيكل الفنيّ ) للقصة يساعدنا على فهم ( الهيكل الفكري ) لها:
لقد قالت القصة عن الجنتين الأوليين:( وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَنّتَانِ ) ، هذه البداية القصصية تؤشر إلى أنَّ ( الخوف) - الذي يعني: عدم الوقوع في المعصية - هو الذي يسم أبطال الجنتين المذكورين، في حين لم ترد السمة المتقدمة في رسم الجنتين الأدنى منهما.
كما أنّ نهاية الرسم الذي طبع هاتين الجنتين، وسَمَ أبطالهما ( بالإحسان ) ومجازاته بمثله:( هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلّا الْإِحْسَانُ ) .
والإحسان - كما نعرف - لا يأْخُذْ دلالته اللغوية إِلاَّ مع افتراض أعلى درجات التقوى... وهذا فيما يتصل بداية القصة ونهايتها.
أمَّا فيما يتصل بالرسم البيئي لكل من ( الموقعين )، فإنَّ ( الفارق ) بينهما سيّوضح تماماً بأنَّ ( الموقع ) الأول للطبقة العليا، و( الموقع ) الآخر للأدنى منها.
إنَّ العناصر المشتركة في الموقعين هي: الزرع، الماء، الفاكهة، الفرش، الحور.
فيما يتصل بالزرع يُلاحَظ أنَّ الموقع الأول:( ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ) والآخر( مُدْهَامَّتَانِ ) طبيعي. إنَّ مرأى الأغصان وهي متدلّية بالقياس إلى مرأى الشجر وهو مكثّف، أو ذو خضرة شديدة، أشدّ إمتاعاً من كثافة الزرع. مضافاً إلى أنَّ الأغصان تقترن بمشاهد الثمر، وبتفريعاته التي قد تغطيّ مساحة كبيرة من الموقع، ( تعوّض ) عن الكثافة النوعية أو الكمية التي يتميّز بهما الموقع الأدنى... هذا فيما يتصل بعنصر ( الزرع ).
وأمَّا ما يتصل بعنصر الماء، فالموقع الأول فيه( عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ) والأخر( عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ) ، وقد يبدو لأول وهلة أنَّ العين النضَّاخة - أي الفوّارة - أشدّ إمتاعاً من العين الجارية. بَيْد أنَّ التأمّل الدقيق يدلنا على الضد من ذلك، فالعين الفائرة تأخذ شكلاً ( رتيباً ) من حيث حركة المياه صعوداً ونزولاً، في حين تتّجه العين الجارية إلى تفريعات مختلفة في حركتها، هذا فضلاً عن الظواهر ( النفعية ) التي تصاحب العيون الجارية من حيث تيسير التناول منه: شرباً أو غسلاً أو ركوباً.
العنصر الثالث من البيئة القصصية هو: الفاكهة. فالموقع الأول فيه:( مِن كُلّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ) ، والآخر فيه( فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمّانٌ ) . إنَّ النخل والرمان - كما تقول النصوص المفسِّرة - يشكّلان بالنسبة إلى عصر نزول النص أفضل الفواكه، بمعنى أنَّ القصة تريد أن تقول لنا: إنّ في الموقع الأدنى جميع الفواكه بما فيها أفضلهما: النخل والرمان. لكنّنا حين نتّجه إلى (الموقع العلوي ) نجد أنّه ينطوي على ذلك أيضاً، ولكنْ بإضافة أخرى هي: ( زوجية ) الفواكه، مثل العنب الرطب واليابس لا النوع الواحد منهما.
العنصر الرابع هو: الفرش. ففي الموقع ( العلوي ) نجد الأبطال:( مُتّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنّتَيْنِ دَانٍ ) ، في حين نجد أبطال الموقع ( الأدنى ):( مُتّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيّ حِسَانٍ ) . إنّ ( الترف ) الذي يصاحب جلسة الأبطال العلويّين يظل من التنوّع إلى الدرجة التي جُعِلت فرشهم ذات ( بطانة ) و( ظهارة ) من نمط خاص. فالبطانة من ( استبرق )، حرير، ديباج.... أمّا ( الظهارة )، فقد سكت النصُ عنها، لسبب ( فنيّ ) هو: ترك القارئ يستخلص بنفسه نوع الظهائر التي أُزينت بها الفُرش.
مضافاً لذلك: ثَمَّة سمة ( فنّية ) أخرى يستخلصها القارئ عن مدى الترف الذي ينعم به الأبطال، من حيث النعومة والرقة والإمتاع حين تستند ظهورهم على كُتلة من الديباج: من حيث بطانته. أمَّا متكأ الأدنين
درجة منهم، فهو: ( الرفرف ) الذي قد يكون قماشاً أو شيئاً آخر موسوم بطابع ( الاخضرار )، و( العبقري ) الذي قد يكون بدوره فراشاً خَلعت القصةُ عليه طابع ( الحُسن)... والفارق بينهما ( أي الموقعين ) من الوضوح بمكان كبير.
والملاحظ ( من الزاوية الفنية في رسم البيئتين ) أنَّ الأوصاف التي خُلعت على الفرش لدى الأبطال الأدنين، هو: ( المتعة الخارجية ). حيث إنَّ الرفرف ( خضر الألوان ) والعبقري ( حسان ) الأشكال، أي أنّ المشاهد يلحظ أشكالاً حسنة وألواناً خضراء، وليس حيال بطائنها من وسائد وأقمشة كونها حريراً أو شيئاً آخر مثلاً. ومن الواضح ( فنّياً ) أنَّ رسم الفرش من داخله يكشف عن مظهره الخارجي، فحين يكون الداخل من ( استبرق ) فإنّ ( خارجُه ) سيكون مصحوباً بترف أشدّ. أمّا حين يكتفي النص برسم ( المظهر الخارجي )، فإنَّ ذلك لا يكشف بالضرورة عن تماثله للمظهر الداخلي.
هنا نلفت الانتباه إلى خصيصة فنية جديدة في رسم هذا العنصر: ( الفرش )، فالملاحظ أنّ القصة القرآنية - من حيث ( عمارتها ) - جعلت لكل عنصر من عناصر الجنة مكاناً خاصاً به دون أن تُداخِل بينها، في حين نلحظ أنَّ ( إضافة ) جديدة رسمها القصة لأبطال الموقع العلوي، وهو:( جَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ) ، فهذه السمة كان من المفروض ( فنِّياً ) أن ترسم مع العنصر الأول ( الزرع )، فلماذا رسمته في مكان يتصل بالفرش ؟ الجواب - من الزاوية الفنية - هو: أنَّ القصة في صدد رسم امتياز جديد للأبطال العلويين، من حيث جلوسهم ومستوياته المترفة التي تصل بين جلوسهم وتناولهم للفاكهة.
إنَّ هؤلاء الأبطال، تظل ثمار الجنة على مقربة من أفواههم( مُتّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنّتَيْنِ دَانٍ ) ، في حين أنّ أبطال الدرجة الأدنى منهم لا يطبعهم مثل هذا ( الترف )، الذي تساوق فيه امتياز فُرُشهم مع طريقة تناولهم للفاكهة، بحيث لا يكلّفون أنفسهم أدنى حركة ( من فرشهم المذكورة ) لتناول الطعام، بل تتدلّى الفواكه عليهم وهم على وسائدهم...
إذن [ وحتى الآن من سير البحث ]، أدركنا المبنى الهندسي الفائق في ( تقطيع ) القصة لشريحة تتصل بعنصر ( الزرع )، ونقلها إلى عنصر يتصل ب- ( الفرش).
العنصر الأخير من البيئة التي رسمت كلاً من موقعي الأبطال: الأعلى والأدنى درجة، يتصل ب- ( الحُور )، فيما ورد رسم يتصل بكونهن مثل ( الياقوت والمرجان ) للأبطال العلويين، فيما لم يرد ذلك في الرسم المتصل بالأبطال الأدنى درجة.
إنَّ أهمية السرد القصصي لموقعَي الجنّة اللذين وقفنا عندهما، ليس هو مجرد الهيكل القصصي الذي لحظنا عمارته الفنية وطريقة التوزيع الهندسي لعناصرهما البيئية، بل يتجاوزه إلى ذلك التلاحم العضوي بين ( موقعَي ) الجنة، وإفادتنا - نحن القرَّاء - من الهيكل القصصي المذكور في تعديلنا لظواهر السلوك. فأدنى تأمّل لموقعَي الجنة، وملاحظة مستويات ( الترف ) التي رسمتها القصة، يُداعي بأذهاننا إلى الموازنة بين ( الإشباع ) في الحياة
الآخرة في أعلى درجاته التي لا يمكن تحديدها، بما يتطلّبه - مقابل ذلك - من ( التنازل عن الإشباع ) في الحياة الدنيا... الإشباع هناك ( في الجنة ) يتناسب طردياً مع ( التنازل ) عنه هنا ( في الدنيا )، وهو أمرٌ حدَّدته البداية القصصية حينما استهلّت العرض الفني لبيئة الآخرة بهذا النحو:( وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَنّتَانِ ) ، فيما قلنا: أنَّ ( الخوف ) يعني: عدم الوقوع في المعصية، وهو أمرٌ يتطلّب ( التنازل ) عن ( الذات ) بمختلف حاجاتها النفسية والحيوية.
٣ - العنصر الصوري
( الصورة ) تُعدّ أبرز العناصر التي تشكِّل مفهوم ( الفن ) وتفصله عن لغة ( العلم )، على نحو ما تحدَّثنا مفصَّلاً في الحقل الأول من هذا الكتاب، حيث أوضحنا بأنّ وظيفتها تتمثّل في إحداث علاقة جديدة بين الأشياء ؛ لتعميق الدلالة الفكرية التي يُستهدَف توصيلَها إلى المتلقِّي.
إنَّ ما ينبغي تأكيده هنا أنّ نجاح الصورة يتوقّف على توفّر عنصرين فيها، هما: الأُلفة والطرافة. ويُقصد بالأُلفة أن تكون الصورة في أطرافها أو أحدها من الظواهر التي نخبرها في الحياة اليومية، مثل ( الجراد المنتشر ) في الصورة القرآنية القائلة عن انبعاث البشر في اليوم الآخر:( يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ) ، فانتشار الجراد من الظواهر التي نخبرها حسِّياً ولا نحتاج إلى أعمال الفكر في تشخيصها.
وأما المقصود من ( الطرافة )، أن تجيء الصورة في تركيبتها العامة ذات جِدَّة لا أن تكون ( مبتذلة ) في الاستخدام. فالجراد المنتشر بالرغم من كونه ( مألوفاً ) في خبراتنا اليومية ( وهو أحد طرفي الصورة )، فإن المركب النهائي لهذا الطرف - وهو انتشار الجراد - وللطرف الآخر - وهو انبعاث الأجساد - يتميّز بكونه ( طريفاً )، لا ابتذال فيه من حيث الاستخدام الفني له.
والأمر نفسه في صور من نحو:( كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ ) ،( إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ) ،( كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ) ،( كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ) ،( أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً ) ،( عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ) ... فالنخل والخشب واللؤلؤ واللحم والأقفال والأنعام تظل من الظواهر التي نألفها جميعاً، كما أنها - في الآن ذاته - تكتسب طابع( الطرافة أو الجِدَّة ) في المركبّ النهائي لها.
المهم أن النص القرآني يتميّز بهاتين السمتين في تركيب الصورة بالنحو الذي أشرنا إليه.
والآن إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن الصورة الفنية تقوم على عنصرين أو طرفين، ينتج من تفاعلهما مركبّ جديد، وكون ذلك يحكمه طابعا الألفة والطرافة ؛ حينئذٍ تثار أمامنا ( أداة )
التفاعل أو الأداة التي تقوم بعملية ربط بين طرفي الصورة، وهي أداة سبق التحدّث عنها في الحقل الأول من هذا الكتاب، حيث أشرنا إلى أن ما يُطلق عليه اسم ( التشبيه ) في المصطلح البلاغي، يُعدّ التجسيد الواضح لمثل هذه الأداة، كما أشرنا إلى أن الأداة المذكورة قد تُحذف في صور بلاغية أخرى مثل: الاستعارة والرمز ونحوهما... بَيْد أن المهم هو: أن نشطر الصورة إلى نمطين في الاستخدام القرآني لها: أحدهما ما يعتمد ( أداة ) المقارنة أو التفاعل بين طرفي الصورة، والآخر لا يعتمد ذلك. والمهم أيضاً أن تقرّر بأن السياق أو الموقف هو الذي يحدّد مشروعية أحد نمطي الاستخدام(١) .
في تصوّرنا أن التعبير عن العمليات النفسية يتطلّب حذف ( الأداة )، في حين يتطلّب التعبير عمّا هو حسّي أو حركي: وجود الأداة.
إننا نواجه عشرات الصور القرآنية ذات البعد النفسي، من نحو:( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ ) ،( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ) ، فالموقف من جانبٍ، وكونه مصحوباً بعملية نفسية من جانبٍ آخر، يفرض أمثلة هذه الصور التي حذفت فيها أداة المقارنة. إن نَضْرَة الوجه أو نعومته انعكاسٌ لفرح الأعماق حالة تسلّمه درجة الفوز برضا الله تعالى.. كما أن صوراً من نحو:( إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً ) ، ونحو:( يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ) .. كان من الممكن - مثلاً - أن تصاغ الصورة الأولى بهذا النحو: ( يوماً كالوجه العابس ) بدلاً من حذف أداة المقارنة، لكن بما أن هول الموقف يحفر في عصب المُشاهد آثاراً بالغة الشدة ؛ حينئذٍ فإن انعكاسها في ( عبوس الوجه )، يظل مرتبطاً بتجربته النفسية ذاتها، دون الحاجة إلى تذكيره بها من خلال المقارنة بوجه عابس. فالعبوس وحده كافٍ بتذكره بالشدة النفسية التي يخبرها بسهولة.
وهذا على العكس - مثلاً - من الصورة المقترنة بأداة من نحو:( أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآَنُ مَاءً ) ، فهذه الاستجابة تتصل بهول الموقف الأخروي أيضاً، إلاّ أن النص مادام مستهدفاً لفت النظر إلى ( العمل ) الذي يصدر عن الكافر، وليس ( الخبرة النفسية ) التي يصدر عنها، حينئذٍ فإن التوسل بأداة التشبيه تفرض مشروعيتها لكي يتبيّن بوضوح أن عمل الكافر يشبه ( في نتائجه التي يتسلّمها أخروياً ) تطلع الظمآن إلى ماء يتناوله ولكنَّه يجده سراباً. لذلك في المرحلة التالية لهذا التشبيه، تجيء الاستجابة المؤلمة التي يحياها الكافر، مطبوعةً بسمة العملية النفسية التي نحتاج إلى رصدها من خلال الأداة، وهذا من نحو:( وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ * تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ) ، ومثل عبوس اليوم الآخر.
____________________
(١) أنظر: ص ٢٠ من هذا الكتاب.
هنا، بعد أن لحظنا نمط الاستخدام القرآني للصورة من حيث أطرافها وأدواتها تتّجه إلى مستويات تركيبها، وهو تركيب ينشطر أساساً إلى نمطين رئيسين، هما: الصورة المفردة والصورة المكثفة.
الصورة المفردة : تستقل بذاتها على نحو منفرد، مثل:( يَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ ) ،( شَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ ) ،( أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ) ... إلخ، حيث تصاغ بنحوٍ إفرادي، دون أن تنضم أليها صور أخرى، وهو ما يطبع:
الصورة المكثفة : حيث تتألّف من صور متعدِّدة، تشكّل بمجموعها صورة كلية، مثل:( كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ... ) ، فهناك مجموعة من الصور ( المفردة ) تتساند فيما بينها لتؤلّف صورة موحّدة كبيرة تنتظمها جميعاً.
المهم أن الاستخدام القرآني لهذين النمطين يفرضهما ( السياق ) الفني أيضاً. فالنص القرآني حينما يستهدف لفت النظر إلى ظاهرة سريعة في سياق ظواهر أخرى، يقتنص حينئذٍ صورة مفردة مثل:( أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ) ، فصورة ( الأقفال ) - وهي مفردة - فرضها سياق سريع هو تدبّر القرآن.
إلاّ أن النص القرآني حينما يعتزم لفت النظر إلى الظاهرة الكونية بعامة، وما ينبغي أن يواكبها من إمعان الفكر وما يترتّب على ذلك من ( الإيمان ) مثلاً، عندئذٍ فإن عدم التدبّر للظاهرة الكونية في مستوياتها المشار إليها، تطلب صياغة صور متعددة تتناسب مع تعدّد المستويات المذكورة ؛ لذلك نجد على سبيل المثال أن النص القرآني يتقدّم بحشد من الصور المتتابعة ذات الطابع ( المركب ) في حديثه عن سلوك الكافرين، مثل:( ظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ) فالصور هنا تتابع لتؤلِّف صورة موحّدة ذات طابع كلي، يتناسب مع سلوك الكافر وهو يحيا التيه والخبط والانغلاق الفكري، حيث عقّب النص على السلوك المشار إليه:( وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ) .
طبيعياً أنَّ سحب النور عن الشخص لابد أن يقتاده إلى أن يحيا الظلام بكل مستوياته، بحيث لا يصدر عن عمل إلاّ ويكتنفه الضلال والخبط والتيه، وهو أمرٌ يتطلّب صياغة صورة شاملة تضم تحت أجنحتها صوراً جزئية متنوّعة تتناسب مع تنوّع الظلمات التي يحياها الكافر.
وأيّاً كان فإن النمط الآخر من الصورة - أي المركبة - تأخذ أشكالاً متنوّعة من التركيب تتحدّد وفق السياق الفني الذي يتطلّب ذلك.
[ أنماط الصور القرآنية: ]
ونقف عند كل نمط منها:
الصورة المفردة المفصَّلة:
وهي صياغة مفردة، لكنَّها تتضمّن سمتين فصاعداً، مثل:( يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ) ، فقد تضمّنت هذه الصورة المفردة سمتين، هما: الجراد أولاً، وكون ذلك منتشراً ثانياً. وأهمية هذا النمط من الصورة تتمثّل في رصد أكبر عدد من عناصر الاشتراك بين طرفي الصورة: ( الخروج من الأجداث )، و( انتشار الجراد ).
فهذه الصورة تتضمّن جملة من العناصر المشتركة بين الانبعاث والجراد: فهناك - أولاً - عنصر ( الانبعاث )، حيث (يخرج) كل طرف منهما من موقع. وهناك - ثانياً - عملية الانتشار، حيث يبدأ كل طرف ( بالتحرّك ) من الموقع المذكور. وهناك - ثالثاً - عنصر ( العشوائية )، حيث تطبع حركتهما مرحلة غير محدودة الاتجاه. وهناك - رابعاً - عنصر ( التراكم )، حيث إن سقوط الجراد لا يأخذ موقعه المنتظَم في الحركة. وهناك - خامساً - عنصر ( الفزع ) الذي يرافق العملية. وهناك - سادساً - ( مجهولية ) المصير الذي ينتظر المرحلة... إلخ.
إن تعدُّد عناصر الاشتراك بين طرفي الصورة يفسِّر لنا ضرورة تعدّد سماتها ضمن صورة مفردة: لأن عملية الخروج من الأجداث تتم بنحو فجائي سريع، لا يتطلّب إلاّ صياغة صورة ( مفردة )، لكن بما أن الانبعاث السريع يقترن بجملة من المظاهر ؛ حينئذٍ فإن تعدّد السمات - تبعاً لتعدد المظاهر - يفسّر لنا كون هذه الصورة المفردة تقترن بأكثر من سمة.
الصورة المكثّفة:
وهي الصورة المركبة من صور جزئية تتكثّف في عَرضٍ واحد من الرصد للظاهرة، مثل صورة:( أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آَذَانِهِمْ ) ، فالصيِّب والظلمات والرعد والبرق صورٌ جزئية تتلاقى في عرض واحد، تشكِّل صورة الشاملة للتيه الذي يحياه المنحرفون، حيث جاءت الصورة في سياق الحديث عن المنافقين، وكونهم صُمَّاً بُكْمَاً عُمْيَاً، وهي سمات تتلاقى فيما بينها لدى سلوك المنحرفين، فيما تفسّر لنا سر ( التكثيف ) الذي يطبع هذا النمط من التركيب الصوري.
الصورة البيانية:
يتميّز هذا النمط من التركيب الصوري بكشف الدلالات التي صيغت الصورة من أجلها، بحيث تتكفّل الصورة بتوضيح منحنيات الظاهرة المشار إليها، من خلال قيام الصور الجزئية بعملية الكشف، مثل الصورة التي تزاوج بين قساوة اليهود والحجارة:( فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا... ) فالصور الجزئية من نحو تفجير الأنهار وتشقُّق الماء والخوف من الله تعالى.. تقوم بمهمة فنية هي: تبيين وتوضيح حجم القساوة التي تفوق حتى الحجر، طالما نجد من الحجر ما يتفجّر منه النهر، وما يَشَّقَّقُ منه الماء، وما يخاف من الله تعالى.
أما المسوّغ الفني لهذا النمط من تركيب الصور، فيتمثَّل في كون الظاهرة المبحوث فيها ذات بُعد نفسي، من المتعذّر على القارئ أن يتمثَّل ويعي ويخبر مستوياتها إلاّ من خلال الصور التوضيحية، فالقساوة قد تكون ذات حجم عادي وقد تكون ذات حجم كبير، إلاّ أن الشخصية اليهودية ما دامت متميّزة طوال التأريخ بسمة عدوانية، لا تضارعها عدوانية الأفراد أو المجتمعات الأخرى، بخاصة أن سورة البقرة قد توفّرت على قصص مختلف أنماط السلوك العدواني لدى اليهود، من نحو نبذهم للعهود وقتلهم الأنبياء وكفرانهم بنِعَم الله تعالى، وتمرُّداتهم المتكررة، فيما يشكّل مثل هذا السلوك حجماً متميّزاً من قساوة القلب لا تضارعه قساوة أخرى، ومن ثَمَّ يتطلّب إبراز مثل هذا الظاهرة صوراً بيانية توضّح وتحدِّد مستويات القساوة المشار إليها.
الصورة التفريعية:
يتميّز هذا النمط من التركيب الصوري، بكون الصور الجزئية منتسِبة إلى صورة رئيسية تتفرّع عنها صور جزئية، تأخذ طابع التفريع: كل صورة تتفرّع عن سابقتها أيضاً، وهذا من نحو( كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآَزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ... ) ، ونحو:( كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ... ) ، ونحو:( كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ... ) .
فالصورة الأُولى تتضمّن صوراً جزئية رئيسة، هي: ( الزرع )، ثم يتفرّع عنها صورة جزئية هي ( الشطأ )، ثم شدّه، ثم تقويته، ثم استواؤه. كما أن الصورة الثانية تتضمّن صورة جزئية رئيسة، هي: ( الحَبَّة )، ثم تتفرّع عنها صورة ( السنابل السَّبع )، ثم تتفرّع عن السنابل السبع صورة ( مئة حبة ) في كل سنبلة.. إلخ.
والأمر نفسه بالنسبة إلى الصورة الثالثة: حيث تتضمّن صورة جزئية رئيسة هي ( المشكاة)، وتتفرّع عنها صورة ( المصباح ) في داخلها، ثم تتفرّع عن المصباح صورة ( الزجاجة ) التي تكتنفه... إلخ.
أما المسوغ الفنّي للصور التفريعية، فتتمثّل في طبيعة الظاهرة المبحوث عنها، حيث تتميّز هذه الظاهرة - وهي: الإنفاق مثلاً - بكونها قائمة أساساً على ( النماء ) الذي يترتّب على الإنفاق، فالمنفِق تتنامى أمواله على نحو تنامي الزرع، وحينئذٍ فإن عملية ( تفريع ) الصور بعضها عن الآخر تتجانس مع ( تفريع ) الزرع كما هو واضح.
والأمر نفسه بالنسبة إلى المؤمنين أو أصحاب محمدصلىاللهعليهوآلهوسلم ، حيث كانوا في بداية أمرهم ضعفاء قليلين، ثم من خلال تضامنهم وتشددّهم على الكفار أصبحوا أقوياء( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ) ، تماماً كما هو طابع الزرع الذي يبدأ ضعيفاً ثم يأخذ في النمو والاستواء
والقوة في نهاية المطاف.
وأما صورة ( المشكاة )، فتكتسب نفس الطابع ( التفريعي )، لكن من خلال تصوّر آخر، هو: أن الصورة تتحدّث عن ( النور )( اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.. ) ، حيث يترتّب على التعامل مع ( النور ) معطيات مختلفة يتفرّع أحدها عن الآخر: فالإيمان يقود إلى الطاعة، والطاعة تقود إلى المعطيات دنيوياً، وهذه تقود إلى المعطيات أخروياً... وهكذا ( ومنها معطيات الله تعالى ). إن المشكاة والمصباح والزجاجة وسائل لتمرير النور وإشاعته: حيث يتدفّق النور من المصباح، ثم ينفد من الزجاجة، ثم ينتشر من خلال المشكاة في الخارج. فإذا أخذنا بنظر الاعتبار أن ( النور ) هو مطلق الخير، حينئذ فإن كل معطي يقود إلى معطي آخر أو ينفذ إلى معطي آخر، وهكذا.
إذاً: الصورة التفريعية تأخذ مسوّغاتها فنياً وفق الطبيعة التي تنطوي عليها الظاهرة المبحوث عنها بالنحو الذي لحظناه.
الصورة المتداخلة:
هذا النمط من التركيب الصوري يتميّز بطابع خاص له إثارته ودهشته الفنية الملحوظة، حيث يعتمد التركيب الصوري على تركيب مثله في صياغة الصورة، بحيث تصبح الصورة ( ازدواجية ) في تركيبها، وهذا من نحو قوله:( لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنّ وَالْأَذَى كَالّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ ) .
فالطرف الآخر من الصورة التي تتركَّب من ظاهرتين، هما: الصدقة المشفوعة بالمَن، ثم الإنفاق على نحو الرياء: هذا الطرف الأخير ( أي المشبَّه به في المثال المتقدِّم ) يعتمد بدوره على طرف آخر ( أي مشبَّه به آخر ) في تركيب الصورة، وهو: ( فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ... )، بحيث يكون الطرف الآخر ( ازدواجي ) التركيب. فالمألوف في تركيب أية صورة أن يكون موضع المقارنة نفسه موضع مقارنة أخرى أيضاً، فهذا من الدهشة الفنية بمكان، وهو ما نلحظه في الصورة المركبة المشار إليها.. فالآية المذكورة تقول: لا تبطل الإنفاق بالمَن كما يبطل المرائي إنفاقه بالرياء، ثم تقول: إن المن والرياء يشبه الحجر الأملس الذي يعلوه التراب، فيصيبه المطر فيجعله صلداً قد أزيح التراب عنه، حيث لا يمكن إعادة التراب إليه بعد الإزاحة...
هذا يعني أن ( التشبيه ) قد اعتمد على ( تشبيه ) مثله في صياغة الظاهرة، وهو أمر - كما قلنا - ملِفت للنظر بما ينطوي عليه هذا التركيب من دهشة وطرافة وإثارة فنية بالغة الدلالة.
والمسوِّغ الفني لهذا النمط من التركيب عائدٌ إلى طبيعة السياق الذي ترد الصورة من
خلاله، فالصورة وردت في سياق مقطع كبير خُصِّص للحديث عن الإنفاق ومستوياته عِبر آيات تحوم على هذا الجانب، مركزِّة على أن يكون الإنفاق في سبيل الله فحسب، دون أن تشوبه أيَّة رائحة من الذات، حتى إنها قرّرت بأنَّ عدم الإنفاق مصحوباً بالكلام الحسن، أفضل من الإنفاق مصحوباً بالمَن والأذى.
حينئذٍ فإن مثل هذا الموقف يستدعي الركون ليس إلى تركيب صوري يقارن بين المَن والرياء فحسب، بل إلى تركيب يزاوج بين المَن والرياء من جانب وبين عملية الحجر الذي أصابه وابل من جانب آخر، حيث تتأدَّى جملة من الوظائف الفنية من خلال من هذا التركيب، منها: أن الرياء - وهو أشدّ الممارسات مفارقة وبطلاناً للعمل - حينما يُقارن بالإنفاق المصحوب بالمَن، إنما يعمّق من قناعة المتلقِّي بخطورة هذه المفارقة ؛ بصفة أن المقارنة أو تشبيه الشيء بآخر إنما يتم من خلال كون الشيء الآخر أكثر مفارقة - أو مماثلاً - له.
ولذلك ما أن أتمّ التركيبُ الأول هذه الصياغة المفصِحة عن خطورة الإنفاق المصحوب بالمَن، حتى أردفها بصياغة صورة تضع كلاًّ منهما - أي الإنفاق المصحوب بالمَن، والرياء - في عرض أو صعيد مماثل، حينما قارنت بينهما وبين الحجر الأملس الذي يعلوه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً..
إذاً أمكننا أن ندرك أهمية الصورة الازدواجية أو المتداخلة، من حيث المسوّغ الفنّي لها، وتميّزها عن التراكيب الصورية الأخرى التي تقدَّم الحديث عنها.
الصورة التمثيلية:
ويقصد بها: الصورة المركَّبة القائمة على حكاية ذات طابع قصصي واقعي أو مفترض، لا تتجاوز نطاق البطل الواحد أو الحادثة المفردة العابرة.. وهذا من نحو الصورة التالية التي تفترض حادثة وبطلاً بهذا النحو:( أَيَوَدّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنّةٌ مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلّ الّثمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرّيّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ... ) .
هذه الصورة وردت في سياق الحديث عن الإنفاق.. وبدلاً من أن تتصدّر الطرف الآخر أداة تشبيه أو تمثيل: بدلاً من ذلك جاءت ( الحكاية ) مباشرة تشكّل الطرف المشار إليه. الحكاية من الوضوح بمكان.. إنها ( تفترض ) وجود بطل يمتلك مزرعة من نخيل وأعناب.. ذات أنهار جارية.. ذات ثمرات من جميع الأنواع.. وأصاب البطلَ الكِبَرُ.. وهو ذو ذرية ضعفاء.. فجأةً يكتسح المزرعَة إعصارٌ فيه نار، فتحترق المزرعة.
من البيّن أن هذه الحادثة التمثيلية يَسِمُها طابع ( الحكاية ) أو الأُقصوصة، بما ينتظمها من بطل رئيس ( صاحب المزرعة )، وأبطال ثانويُّون ( الذرية)... وبما ينتظمها من وجود ( حادثة ) الإعصار، وبيئة ( المزرعة )... وبما تواكبها من أداة الصياغة القصصية، مثل
عنصر ( المفاجأة ) وعملية احتراق ( المزرعة ).. وهذا يعني أن عنصر المقارنة ( تشبيهاً أو استعارةً أو رَمزاً أو مطلق الصورة الفنية ) قد اعتمد ( الحكاية أو الأُقصوصة ) بدلاً من أداة التشبيه أو الاستعارة أو الرمز...
طبيعياً ثَمَّة مسوِّغ فني لأنْ تُصاغ الصورة ( حكاية ) بدلاً من مجرد التركيب لظواهر عامة، ففضلاً عن جمالية هذا النمط من التركيب الصوري الذي يعتمد الحكاية عنصر مقارنة أو مزاوجةٍ، نجد أن الأُقصوصة أو الحكاية لها وظيفتها المتميّزة في التعبير عن الظاهرة المبحوث عنها. فسواء أكان الهدف منها هو إبراز الندم الذي يصدر عن المرائي مثلاً، أو المنغمس في متاع الحياة أو غيرهما، فإن المهم هو إبراز المفهوم المشار إليه: أي ( الندم)، طالما نعرف بأن من الندم ما ينحصر في إشباعات غير ضرورية.. ومنه ما يتلافى مثلاً.
إلاَّ أنّ من الظواهر ما لا يحتمل الندم عليها، بل يظل التمزّق والانسحاق والانشطار النفسي يُلاحق الشخص، مثل الحكاية التي افترضتها الصورة الفنية التي نحن في صددها. إن المزرعة هي المصدر الوحيد للشخص المشار إليه، يتوقّف عليها تأمين جميع حاجاته الرئيسة مثل المطعم والملبس والمسكن، وحاجاته الثانوية في مختلف مستوياتها.. ومن الممكن أن يعوّض الشخص عن ذلك في حالة كونه شاباً، أو كهلاً بمقدوره أن يلتمس مصدراً آخر للرزق، كما يمكن لذُرِّيته - لو كانوا كباراً - أن يتولّوا نفقته ونفقتهم.. إلاّ أنه وقد كَبِرَ دون أن يستطيع عمل شيء ما، كما أنه مسئول عن ذرية ضعفاء: حينئذٍ فإن تأمين حاجته من جانب، وحاجة الذرية من جانب آخر، يظل أمراً لا يمكن تلافيه ؛ ممَّا يستتلي وقوعه في صراع وتمزّق لا حدود لهما، طالما لا يسعفه التحسّر أو الندم على ما أصاب مزرعته من الاحتراق..
إذاً سرد مثل هذه ( الحكاية ) أو الأُقصوصة، ينطوي على مهمة فنِّية في غاية الخطورة، حينما تصاغ في تركيب صُوَري يستهدف لفت النظر إلى الندم والحسرات التي تلحق الشخصية في اليوم الآخر، عندما يجد أن الإمتاع الدنيوي الذي غرق فيه قد انحسر تماماً، حيث لا ينفعه الندم على ما فاته من التقصير العبادي.
ومن الواضح أن تعميق مثل هذا المفهوم من الممكن أن يتم وفق صورة تركيبية حيوية ( أبطال، حوادث، بيئات )، بما يواكبها من تحليل وتعقيب، وبما تنتظمها من عناصر تشويق مختلفة، حينئذٍ تشدّ المتلقِّي إلى الحكاية أكثر من غيرها، بخاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن صياغة هذه الصورة التمثيلية جاءت عقب صورة حقّقت هدفها الفني، صورة ( الحجر الذي أصابه وابل ) فيما تحدثنا مفصّلاً عنها، كما أنها جاءت في صياغة تساؤل يستهدف تأكيد الحقيقة المشار إليها( أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ.. ) .
كل أولئك يشكّل مسوِّغاً لأنْ تُصاغ الصورة بنحوها ( التمثيلي)، يحقّقه بذلك: عنصر التنوّع في التركيب الصوري من جانب ؛ تحقيقاً لمزيد من الإمتاع الفني.
مضافاً إلى أن العنصر القصصي ذاته ينطوي على إمتاع آخر. ثم عنصر التعميق لهدف خطير هو: حمل الشخصية على تعديل سلوكها قبل أن يمتنع عليها ذلك، علماً بأن نفس هذه الصورة تتضمَّن الهدف المشار إليه.
العنصر الإيقاعي:
في عرضنا للعنصر البنائي والقصصي والصُوَري، نكون قد ألممنا - عابراً - بمجمل السِّمات الفنية للنص القرآني الكريم. وحين نتَّجه إلى العنصر الإيقاعي، نجده ملحوظاً بشكل لافت، لا يكاد يجهله أحد من القرّاء في هذا الصدد. فالسُّوَر جميعاً - عدا النادر - لا تخلو من عنصر ( القرار ) أو ( القافية ) التي تنتهي إليها الآية، مع ملاحظة أن البعض من السور ( تتوحّد ) قوافيها، والغالبية ( تتنوّع ) في ذلك.
وفيما يتّصل بالبُعد الثاني من عناصر الإيقاع، وهو ( التجانس ) بين أصوات العبارة المتنوّعة، فهذا ما لا تكاد أية سورة تخلو منه، حتى إنك لو قرأت سورة ( المُلك ) مثلاً، لوجدتَ أن حروف ( س، ص، ز ) بصفتها تنتسب إلى أصل صوتي واحد، تلاحق عبارة السورة حتى نهايتها، بخاصة ( س - ص )، مثل: أحسن، سَبع، سماوات، البصر، السماء، بمصابيح، السعير، المصير، سمعوا، سألهم، زَيَّنَّا، نَزَّلَ، نسمع، السعير، حاصباً، فَسَتَعْلَمُون، صافات، يُمْسِكُهُنَّ، بصير، ينصركم، يرزقكم، أَمْسَكَ، رِزْقَه، تَمَيَّز، سَوِيَّاً، صراط، مستقيم، السمع، الأبصار، زُلْفَةً، سِيئَتْ، فستعلمون، أصبح...
إنَّ هذه المفردات التي شكّلت نسبة تقريبية ( ٢٠% ) من عدد كلمات السورة بأجمعها، تمثِّل نموذجاً ل- ( التجانس ) الصوتي في العبارة القرآنية الكريمة، وحتى لو فَصَلْنا أحد حروفها، وهو ( س )، لوجدناه يمثّل نسبة تقريبية هي ( ١٢%).
وهذا كله من حيث صلة الصوت بمجموع السورة.
أما صلته بفقرة، أو آية، أو قرار، فأمرٌ من الوضوح بمكان ملحوظ. فلو وقفنا عند نفس السورة، لوجدنا - مثلاً - هذه الفقرة:( وَلَقَدْ زَيّنّا السّماءَ الدّنْيَا بِمَصَابِيحَ ) ، للحظنا التجانس الصوتي في حروف ( السين والصاد والزاي ) في( وَزَيّنّا السّماءَ الدّنْيَا بِمَصَابِيحَ ) ، وهكذا في فقرة( فَسُحْقاً لِأَصْحَابِ السّعِيرِ ) ، ومثلهما( الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ ) ، ومثلهما( سَوِيّاً عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) ، ومثلها( السّماءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ
حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ ) ومثلها( يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ) ، فحتى مع افتراض أن نسبة الصوت إلى مجموع السورة قد ينسحب على سور كثيرة أخرى، حينئذٍ فإن تجانس حتى فقرة واحدة يعدّ إفصاحاً عن جمالية العبارة المذكورة.
ففي السورة ذاتها مجموعة من الفقرات المتجانسة ( صوتياً ) من حروف أخرى مثل:( وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السّعِيرِ ) حيث يجيء الحرف ( ع ) هو العنصر المُجانس بين الأصوات. إنه من الممكن حالة قِيام أحد الباحثين برصد هذا الجانب لسور القرآن الكريم، أن يكتشف أسراراً صوتية بالغة المدى، ليس في حدود السمة الجمالية فحسب، بل: السمة الإعجازية أيضاً (١)، كما أن رصد العلاقة بين الدلالة والإيقاع: أي بين معنى العبارة وحروفها، يساهم في اكتشاف سمات جمالية بالغة الدهشة. بَيْد أن تناول هذه الجوانب يتطلّب وقتاً قد لا نتوفّر عليه في صعيد التناول المُجمل للفن القرآني الكريم.
____________________
(١) نهضت إحدى الدراسات برصد أوائل السور، مثل:صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو ( ق )... وسواهما، وعلاقتها بمجموعة أصوات السورة، وملاحظة الاطراد بين افتتاحيَّتها ونسبتها الغالبة على سائر الحروف في السورة. ومعلوم أن مثل هذه الدراسة تعزّز الاتجاه المؤكَّد الذاهب إلى عدم ( التحريف ) في القرآن الكريم.
[ أدب السُّنَّة ]
الخطبة:
الخطبة شكل فني يعتمد الإثارة العاطفية عنصراً في صياغته. وبالرغم من أن العمل الفنّي بعامة يظلّ متميّزاً عن التعبير العلمي، بخلو هذا الأخير من العنصر العاطفي وتجسّده في العمل الأول، إلاّ أن النِسَبَ العاطفية تحتفظ بتفاوتٍ ملحوظ من شكل لآخر: ففي حين تكاد القصيدة الغنائية - مثلاً - تتمحّض للعنصر العاطفي، نجد أن العنصر المذكور تضؤل نِسَبُه في الأشكال الشعرية الأخرى، ويكاد يختفي في العمل القصصي في بعض أشكاله ويطغى في أشكال أخرى، وهكذا.
وفيما يتصل بالخطبة، فإن العنصر العاطفي يظلّ طابعاً ملازماً لهذا النمط من الفن، نظراً لطبيعة ( الموقف ) الذي يستدعيه.
ومن الحقائق المألوفة في حقل ( الاجتماع )، أن ( الجمع ) يكتسب سمة جماعية يفقد من خلالها كلُّ فرد سمته الشخصية ليندمج في المجموع. وعملية الاندماج المذكورة تقوم أساساً على ( عاطفية شديدة ). ويحدِّد علماء الاجتماع ثلاث سمات، هذا الجمع هي: الانبهار، الإيحاء، العدوى. وكلّ من السمات المذكورة تقوم على الأساس الانفعالي الذي أشرنا إليه.
ومعلوم أن ( الخطبة ) هي التي تضطلع بمخاطبة هذا ( الجمع )، فيما تستثمر هذه السمات لتمرير أفكارها التي تستهدف إيصالها للجمع، ومن ثَم تستطيع الخطبة أن تكسب ( الجمع ) بنحوٍ لا تستطيع الأشكال الفنية الأخرى أن تحقّقه.
المهم، مادام العنصر ( الانفعالي ) هو السمة المميزة لفنّ الخطبة، حينئذٍ فإن السمة المذكورة ستحدِّد أيضاً بناء الخطبة وسائر عناصر الشكل الذي تقوم عليه. وبالرغم من أن ( الأساس الانفعالي ) الذي تقوم عليه ( الخطبة )، تتطلّب مجرد انتقاء ( المواقف ) وطريقة طرحها، إلاّ أن الأدوات الفنية من إيقاع وصورةٍ، ستساهم دون شك في تصعيد الموقف الانفعالي أيضاً.
من هنا تجيء الخطبة مماثلة لسائر أجناس الأدب الإنشائي، من حيث توفّر العناصر الأساسية الأربعة للفن، وهي: الصوت والصورة والبناء والطرافة.
مع ذلك، فإن ( السمة الانفعالية ) لا تعدّ في كلّ الحالات أمراً ضرورياً في الخطبة، بخاصة فيما يتصل ( بالفن التشريعي )، الذي لا يلجأ في الغالب إلى الاستثارة العاطفية إلاّ في نطاق محدّد، يلتئم مع الجديّة والرصانة اللتين تتميّز بهما الشخصية الإسلامية. حتى في نطاق تجارب الأرض لا يمكننا - في الواقع - أن نقرّ الاتجاه الأدبي الذاهب إلى ضرورة طغيان العنصر الانفعالي في الخطبة، مادمنا نلحظ نماذج كثيرة من أدب الخطبة تحتفظ بالموضوعية، أو لا أقل بالنضج الانفعالي قبال الهياج العاطفي الذي لا يلتئم مع سويّة الشخصية. هذا إلى أن كثيراً من المواقف لا تتطلّب انفعالات حادة بقدر ما تتطلّب طرح الظاهرة بنحوٍ منطقي هادئ، كما لو كان الموقف يتّصل بطرح مفهومات فلسفية عن الكون والمجتمع والإنسان مثلاً.
أخيراً، ينبغي إلاّ نرسم حدوداً فاصلة بين ما ألِفَه الأدب الموروث من ( الخطبة )، وبين ما نألفه في حياتنا المعاصرة من شكل نصطلح عليه ب- ( الكلمة). فكلتاهما - أي الخطبة والكلمة - تخضعان لنفس المعايير التي يستلزمها ( موقف جمعي)، مستعد للاستماع إلى معرفة حقيقة من حقائق الحياة الاجتماعية في تطلّبها تغييراً اجتماعياً ما.
على أيّة حال، يعنينا من العرض المتقدم لفنّ الخطبة أو الكلمة، أن نتّجه إلى ( الأدب التشريعي ) في هذا الصدد، لملاحظة القيم الفنيّة والفكرية التي تنطوي عليها نماذج الفنّ المذكور. وسلفاً سنأخذ بنظر الاعتبار أن الأُسس الانفعالية من جانب، وإبقاء التخوم الفاصلة بين الخطبة والكلمة، سوف لن تبقى موضع عناية كبيرة في النموذج الذي نختاره، فضلاً عن أننا لا نحرص على عرض النماذج بكاملها: إما لعدم وصول البعض من الخطب إلينا كاملةً، أو أن الاكتفاء ببعضٍ من أقسامها كافٍ في التعرّف على قيم الخطبة فنياً وفكرياً.
نموذج (١)
من خطبة للإمام عليّعليهالسلام ، يقول فيها بعد حمد الله ( تع ) والصلاة على نبيّهصلىاللهعليهوآلهوسلم :
( أُوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ضَرب الأمثال، ووقّت لكم الآجال، وألبسكم
الرياش، وأَرْفَغَ لكم المعاش، وأحاطكم بالإحصاء، وأرصد لكم الجزاء، وآثركم بالنعم السوابغ والرفَّد الرَّوَافِغِ، وأنذركم بالحجج البوالغ. وأحصاكم عدداً، ووظَّفَ لكم مُدَداً، في قرار خِبْرَةٍ ودار عِبْرةٍ، أنتم مختَبَرون فيها ومحاسبون عليها. فإن الدنيا رَنِقٌ مشربُها رَدِغٌ مشرعُها، يُونِقُ منظرها ويُوِبقُ مخبرها، غرور حائل وظلّ زائل وسناد مائل. حَتَّى إِذَا أَنِس نافِرُهَا واطْمَأَنَّ نَاكِرُهَا، قَمَصَتْ بأَرجُلِها، وقَنَصَتْ بأَحْبُلِها، وأَقْصَدَتْ بأَسْهُمِها، وأَعْلَقَتِ المرءَ أَوْهَاقَ المَنيَّةِ، قائدةً له إلى ضَنْك المضجع، ووحشة المرْجِع... ).
ثم تتّجه الخطبة أو الكلمة إلى ظاهرة النشور حيث ينتهي بذلك القسْم.
ويعيننا من هذا النموذج أن نعرض عابراً إلى قيمها الفنية أولاً، حيث نلحظ ( القيم الصوتية ) متمثِّلة في ما أسميناه ب- ( القرار الإيقاعي )، ثم ( التجانس )، ثم ( التوازي ). فالخطبة في غالبيتها ذات قرارات متنوِّعة: ( رياش / معاش، سوابغ / بوالغ، حائل / زائل / مائل،... ).
أما عنصر ( التوازي )، فيحتل مساحة ضخمة من النصّ، تكاد تتكافأ مع مساحة (القرارات) ذاتها.
ولنقرأ مثلاً:
مختَبرون فيها - محاسبون عليها
رَنِق مشربها - رَدِغ مشرعها
يُونِق منظرها - يُوبِق مخبرها
قمصت بأرجلها - قنصت بأحبلها
إلخ
حيث إن كلَّ ( قرارٍ ) مسبوقٌ بجملة متوازية مع الأخرى كما هو واضح.
أخيراً: ( التجانس ) الصوتي بين مختلف أنماط العبارة، حتى إنّ ( الجملة المتوازية ) أيضاً تخضع للتجانس بين أصواتها، مثل (يُونِق / يُوبِق، قَمَصَتْ / قَنَصَت )، مضافاً إلى التجانس الذي يتجاوزها ليشمل فقرات لاحقة، مثل الفقرات الثلاث: (قمصت بأرجلها، وقنصت بأحبلها، وأقصدت بأسهمها )، حيث يلاحظ المتذوّق إيقاعاً بالغ المدى في تجانس الأصوات الثلاثةصلىاللهعليهوآلهوسلم ، مضافاً إلى الصوت ( س ) في الفقرة الأخيرة، فيما تتجانس معصلىاللهعليهوآلهوسلم وانتسابهما مع حرف ( الزاي ) إلى مجموعة صوتية واحدة كما هو واضح.
ونتّجه إلى عنصر ( الصورة )، فنجدها محتشدةً في المقطع الخاص بالحياة الدنيا. ولا نحتاج إلى أدنى تأمّل لندرك السرّ النفسي وراء الارتكان إلى العنصر الصوَري في هذا المقطع ؛ متمثِّلاً في الحرص على تعرّفها تماماً، فيما يجيء العنصر الصوَري معمِّقاً ومجلّياً ومبلوراً مفهوم الحياة الدنيا، وفيما تتركّز عندها وظيفتنا الخلافية، فضلاً عمّا يتوقّف عليها مصير الحياة
الأبدية.
والمهم، أن العنصر الصوَري يتلاحق في هذا المقطع الذي استشهدنا ببعض نماذجه، المتصلة برنق المشرب وردغ المشرع، وقمص الأرجل وقنص الأحبل... إلخ. فلو وقفنا - على سبيل المثال - على الصورتين الأخيرتين: ( قمص الأرجل وقنص الأحبل )، للحظنا أنهما تنتسبان إلى خبرات مألوفة يومياً، لكنّها متسمة بالطرافة في الوقت ذاته، وهما سمتا الصورة الناجحة فنياً، أي: قدرتها على الاستثارة. فقمص الأرجل هو ( رفعها وطرحها معاً )، وقنص الأحبل هو ( الاصطياد بحبائلها )، وهذا يعني أن الصورتين تريدان أن تقولا لنا: إن الموت هو النهاية للحياة التي صوّرتها الخطبة قبل هذه الفقرات. إلاّ أن هذا القول تَمَّ من خلال صورتين: أولاهما: تجسّد عنصر ( المباغتة ) التي ترفع الأرجل وتضعها فجأةً لينتهي كل شيء، والثانية: تجسّد عنصر ( المخادعة ) التي تصطاد ضحيّتها بشباكها.
إذن: كلّ من ( المباغتة ) و( المخادعة)، وهما - كما نعرف جميعاً - من أبرز مظاهر ( الحرب )، وأنجح وسائلها في إحراز النصر، يظلان من سمات ( الحياة الدنيا ) في حربها مع الكائن الآدمي... من هنا ينبغي أن ينتبه القارئ إلى أهمية هذا العنصر ( الصوَري ) في الخطبة، بالرغم ممّا يبدو للمتأمل العابر بساطة هذه الصور وأُلفَتَها في الحياة اليومية، إِلاّ أن هذه البساطة أو الأُلفة كانت من العمق والاصطفاء، والغنى والتنوّع، إلى الدرجة التي جسّدت من خلالها أبرز ما يمكن استخدامه في الممارسات العسكرية، التي تفصح عن ( العداء المستحكم ) بين طرفي الحرب.
ولا نعتقد أن ثَمَّة صورة أخرى يمكنها أن تكشف لنا طبيعة المظهر الدنيوي في ( محاربته ) للآدميين، واستخفاء ذلك عليهم، بمثل الصورة المتقدِّمة، بالرغم من بساطة الصورة وأُلْفَتِها في الحياة اليومية، وهي حركة الفَرس المذكورة. وهذا هو ما يفصل بين (فنٍ تشريعي ) لا يصدر عن بشرٍ عادي، وبين ( فنّ وضعي ) لا يمكنه أن يحقّق كل أطراف الصورة الناجحة بالنحو الذي لحظناه.
أما فيما يتصل بالعنصر الرابع من أدوات الفن، ونعني به ( البناء)، فلا يمكننا أن نتحدّث عنه مادمنا قد اخترنا قسماً من الخطبة. علماً بأن أهمية البناء الهندسي للنص لا يمكن أن يتّضح إلاّ بالوقوف على النص بأكمله، لكن مع ذلك يمكننا أن نتعرّف بوضوح على ( نموّ ) مقاطع هذا القسم الصغير الذي اقتطعناه من الخطبة، حيث لحظنا كيف أنها ابتدأت بتعريف الوظيفة الخلافية لنا، وانتقالها إلى رسم معالم ( الحياة الدنيا )، ثم انتقالها إلى حدث ( الموت )، وانتقالها بعد ذلك إلى الحياة (الآخرة )، حيث أخذت كلاً من التسلسل الزمني و
النفسي بنظر الاعتبار، وهو أمرٌ له أهميته الكبيرة في عملية الاستجابة الفنية للنص.
الآن، بعد أن لحظنا عناصر: الإيقاع والصورة والطرافة والبناء، يتعيّن علينا أن نتّجه إلى ( قيمها الفكرية ) وعناصرها ( الانفعالية ) بالنسبة للقارئ والمستمع، وليس بالنسبة إلى صاحب الخطبة بطبيعة الحال.
أما قيمها الفكرية، فمن الوضوح بمكانٍ، وقد لحظناه من خلال العرض السريع لأفكار الخطبة الحائمة على التعريف بطبيعة الحياة الدنيا، وموقعنا العبادي منها.
وأما قيمها العاطفية، فقد لحظنا أن هذا العنصر قد صيغ بطريقة رصينة لا مجال للتهريج الانفعالي فيها، بل إن ( المنطق ) الممتزج بإثارة عاطفية هادئة هو السمة المُحكمة للخطبة.
ولو تابعنا سائر أجزاء الخطبة، للحظنا أن هذا العنصر يتصاعد حيناً ويتراخى حيناً آخر ؛ تبعاً للموقف النفسي الذي نستجيب له حيال هذه الظاهرة أو تلك. فمثلاً نجد أن ( التصاعد ) بالعاطفة يأخذ مساره حين نواجه هذه التحذيرات:
( فاتّقوا تقيّة مَن سمع فخشع، واقترف فاعترف، ووَجِل فعَمِل، وحاذر فبادر، وأيقن فأحسن، وعُبِّر فاعتبر، وحُذِّر فازدجر، وأجاب فأناب ).
بغض النظر عن الجمال الإيقاعي لهذه الفقرات، التي احتفظت كلّ واحدة منها ب- ( قرارين متصلين )، مثل: سمع فخشع، اقترف فاعترف، وَجِل فعَمِل... إلخ، بغض النظر عن هذا الإيقاع الذي احتلّ له صياغةً خاصة في هذا القسم من الخطبة، وأهميّة ( التنوّع ) في أشكال الإيقاع من مقطع لآخر،... بغض النظر عن هذا كله، نجد أن الإيقاع - بشكله المتقدّم - ساهم في ( التصاعد ) بالموقف العاطفي للمستمع والقارئ، حيث جاء توالي الفقرات وتوالي تجانسها - بالشكل المتقدم - متناسباً مع توالي ( التحذيرات )، التي تتصاعد بمشاعرنا إلى أن ( ننفعل ) أكثر بهذه التوصيات، وأن نتحمّس بنحو أشدّ في الإفادة من التجارب، بحيث تصبح فُرصُ ( التعديل ) لسلوكنا أكثر ملائمةً في هذا الموقف.
ثم يتصاعد الموقف ( الانفعالي ) بنا نحو درجة أعلى حينما نواجه هذا التهديد:
( فهل ينتظر أهل بضاضة الشباب إلاّ حواني الهرم، وأهل غضارة الصحّة إلاّ نوازل السَّقَم، وأهل مدة البقاء إلاّ آونة الفناء: مع قرب الزِّيَال وأُزوف الانتقال، وعَلَزِ القلق، وألم المضض... ).
أيضاً، بغض النظر عن العنصر ( الصوَري ) الذي احتشد في هذا المقطع من الخطية، بالقياس إلى العنصر ( الإيقاعي ) الذي احتشد في سابقه،... بغض النظر عن هذا البناء الهندسي الذي يُرْسَم حيناً - في أحد جوانب العمارة - هيكلاً إيقاعياً،
وحيناً آخر - في جانب ثانٍ - منها يُرْسَم صوَرياً، ويُناسَق بين مختلف الجوانب... بغض النظر عن جمالية هذا المبنى الهندسي للخطبة، نجد أن ( التصاعد ) بالموقف الانفعالي يأخذ طابعه الملحوظ، من خلال نقلنا إلى الموجَّهة المباشرة مع وقائع الحياة، فالهرم والسَّقَم والقلق وسواها، تشكّل مظاهر يومية نأسى لها وننفعل بمشاهدتها لدى الآخرين أو لدى أنفسنا بالذات، فالشاب مثلاً حينما يواجه قريباً له قد احتوشه الهرم أو المرض الذي لا شفاء منه، أو المرض الذي لا يسمح بممارسة العمل العبادي المطلوب،... مثل هذا الشاب ( ينفعل ) بالضرورة، حيال مشاهدته أو تذكُّره بأمثلة هذه الوقائع التي يواجهها يومياً.
إذن: التصاعد العاطفي بلغ درجة أعلى من سابقتها في نطاق هذا الموقف الذي يتطلّب مثل هذا التصاعد.
أخيراً، لو تابعنا تمام الخطبة المذكورة، لأدهشنا ما تنطوي عليه من قيم فكرية وعاطفية، مصوغة بطرائق هندسية متنوِّعة من المدّ أو التراخي العاطفيين، فضلاً عن الصياغة الإيقاعية والصوَرية التي لحظنا جانباً من تنوّعها وتواسقها، وفضلاً عن ( البناء ) الضخم الذي ( يوحّد ) بين مختلف أفكار الخطبة وموضوعاتها، وهو أمرٌ نحيله إلى القارئ ليمارس بنفسه عملية كشف لهذا النمط من الفنّ عند أهل البيتعليهمالسلام .
الخطبة المتقدمة تمثّل نموذجاً من النصوص التي تُعنى بقيم الإيقاع والصورة، مصحوبة بدرجات متفاوتة من ملاحظة البُعد ( الانفعالي ) عند المتلقِّي تبعاً للموقف ومتطلباته.
قبال ذلك، نلحظ نماذج أخرى من الخطب التي لا تُعنى بقيم الإيقاع والصورة بقدر ما تُعنى بملاحظة الاستجابة الانفعالية عند المتلقِّي، أو لا تعنى بهذه السمة الأخيرة بقدر ما تُعنى بالعنصر الإيقاعي والصوري، أو لا تعنى بهما جميعاً بقدر ما تحرص على إيصال حقيقة من الحقائق العبادية إلى الجمهور، معوِّضةٍ عن القيم الصوَرية وغيرها بقيم الحديث المباشر مع الجمع، لكن وفق انتقاءٍ للعبارة المثيرة، المتوازية هندسياً، المتعاقبة سريعاً، المنْتَقاة أصواتاً، مع سهولة وإشراق وتمكّن وليونة لفظية.
ولعل خطبة النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم المعروفة، التي ألقاها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تمثّل هذا النمط من الخطب التي تتميّز بما هو ( سهل ) وبما هو ( ممتنع )، ولنقرأ:
( أيُّها الناس، إنَّه قد أقبل عليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. شهرٌ دُعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجُعلتم فيه من أهل كرامة الله: أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم
فيه مقبول....
أُذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه، وتصدّقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقّروا فيه كباركم، وارحموا صغاركم , وصِلُوا أرحامكم، واحفظوا ألسنتكم، وغضّوا عمّا لا يحلّ إليه النظر أبصاركم، وعمّا لا يحلّ إليه الاستماع أسماعكم، وتحنّنوا على أيتام الناس يُتحنّن على أيتامكم، وتوبوا إلى الله من ذنوبكم، وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم... أيُّها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكّوها باستغفاركم، وظهوركم مثقلة من أوزاركم فخفّفوها بطول سجودكم... ).
المُلاحَظ أن هذه الخطبة تبتعث الإثارة، بالقدر ذاته من الإثارة التي نلحظها في خطب أو أحاديث النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم وأهل البيت ( ع )، ذات الطابع الإيقاعي والصوَري، وهذا يعني أن الإثارة الفنية لا تنحصر في نمط محدّد من الإيقاع أو الرسم، بل يتمّ ذلك من خلال أية لغة تأخذ البطانة الانفعالية والفكرية للجمهور المتلقِّي، حيث يكون لتوازن الجمل وتعاقبها أثراً في ذلك، أو يكون للانتقاء الصوتي غير المنتظم في ( قرار ) أثره أيضاً، أو يكون للتسلسل النفسي أو الزمني المصاحب لعرض أفكار الخطبة، أثره أيضاً، وهكذا...
إن الخطبة المذكورة لم تهجر نهائيّاً كلاًّ من الصوت المنتظم والصورة، بل توكّأت عليهما في أمثلة هذا البُعد الإيقاعي:
( وقّروا فيه كباركم، وارحموا صغاركم... وغضّوا عمّا لا يحلّ إليه النظر أبصاركم ).
ومن أمثلة هذا البُعد الصوَري:
( إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكّوها باستغفاركم، وظهوركم مثقلة من أوزاركم فخفّفوها بطول سجودكم ).
ولكن جاء كلٌّ من البُعد الإيقاعي والصوري المذكور، عابراً بالقياس إلى الإيقاع العام لمجموع الخطبة، والرسم العام لمجموعها. فالإيقاع العام يتمثّل في ذلك ( الجرس ) الذي تبتعثه الجمل المتوازية والمتعاقبة والمتكرِّرة:
( شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام , ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات ).
إن كلاًّ من التكرار والتعاقب والتوازي يشكّل ( عناصر ) إثارة لدى المستجيب، لا تقل عن الإثارة التي يبتعثها الإيقاع المنظّم أو الصورة المركّبة. والأهم من ذلك كلّه، أن ندرك بأنَّ السياق هو الذي يتدخل في تحديد هذا العنصر الفني أو ذاك. ففي سياق شهر رمضان المبارك الذي يقترن بخشوع عبادي خاص، لا يجيء الحثّ على استقباله من خلال كثافة
إيقاعية أو صورية، بقدر ما يجيء ذلك من خلال لغة ميسّرة، خاطفة، متوازنة، متعاقبة، آخذٌ بعضها برقاب البعض: حتى يتساوق التطلّع الخاشع نحو هذا الشهر مع تماوج العبارة الفنية التي تحضر في عصب المتلقِّي تطلّعاً يُماثل ذلك.
المهم، أن الخطبة المذكورة تمثّل النمط الآخر من النصوص التي تتميّز بما هو ( سهل ) - كما قلنا - وبما هو ( ممتنع)، من خلال تحسّسنا بإشراقها وسحرها الفني، اللذين يندّان عن إمكان تفصيل الحديث فيهما، بقدر ما يفصحان عن ذاتهما بنحو عفوي نتذوّقه، ولا نعيه بلغة المنطق الفني وتحليله لمقوِّماته.
( الكتاب... )
يمكننا أن نذهب إلى أن هناك نمطاً من الكتابة الفنية، تتميّز عن ( الخطبة ) بكونها لا تعتمد ( البُعد الانفعالي ) للجمهور، بقدر ما تعتمد تقرير مجموعة من الحقائق العبادية بلغة علمية: إلاّ أنها موشّحة بأدوات الفنّ، من قيم صورية وإيقاعية ونحوهما، ممّا يجعلها مثل ( الخطبة )، مندرجة ضمن الشكل الأدبي.
ويتميّز ( الكتاب ) بكونه موجهاً إلى شخص - أو أكثر - أو جهة أو جمهور، ولكن ليس على نحو ( الخطاب )، بل على نحو ( الكتابة ) إليهم.
وهذا النمط من الكتابة يشمل جنسين فنّيين، هما:
١ - الرسالة.
٢ - الوصية.
ويُلاحظ أن كلاًّ منهما قد يفترق عن الآخر في السمات الأسلوبية، إلاّ أنهما قد يندمجان حيناً، إلى الدرجة التي لا نكاد نتبيّن خطوط الفارق بينهما.
( الرسالة ) تتّجه إلى شخص يتحمّل مسؤولية اجتماعية، مثل: القاضي، الحاكم، الموظفين بشكل عام، حيث تدور محتويات ( الرسالة ) حول أمور اجتماعية خاصة لها سمة السلوك العبادي بعامة. بَيْد أن تنفيذها يظلّ على صلة بالموظف المسئول كما قلنا.
أما ( الوصيّة )، فتحوم بدورها على موضوعات عامة، مثل ( الرسالة ) تماماً، كما قد توجَّه إلى شخص محدّد، أو إلى جمهور مبهم، إلاّ أنها - في بعض أشكالها - قد تكتسب بُعداً خاصاً يتصل بالوصيّ أو الموصى له، بحيث تنسلخ من صعيد الشكل الفني إلى مسائل خاصة تتصل بالأموال والحقوق، ممّا لا علاقة لها بموضوع دراستنا.
تأسيساً على ما تقدّم، يمكننا الذهاب إلى أن ( الرسالة ) و( الوصية ) - في شكلها الأول الذي أشرنا إليه - تندرجان ضمن شكل فنّي يتوسّل ب- ( الكتابة ) في توصيل الحقائق التي يستهدفها الكاتب، موجَّهة إلى شخص أو فئة أو جهة، وهذا من نحو ( الكتب ) التي وجّهها الإمام عليّ (ع) إلى الولاة مثلاً، ونحو الوصايا التي وجّهها (ع) لابنه الحسن (ع) والحسينعليهالسلام ، فكلّ من ( الرسائل ) الموجَّهة إلى الولاة، و( الوصايا ) الموجَّهة إلى أفراد بأعيانهم، لا تختلف في مضموناتها الفكرية بعضاً عن الآخر، من حيث كونها ( إرشاداً ) إلى ظواهر عبادية ذات طابع فردي أو اجتماعي ( مع ملاحظة أن الرسائل الموجَّهة إلى الولاة وغيرهم من المسئولين قد تشدّد على السلوك السياسي مثلاً ).
ولكن مع ذلك فإن الموضوعات قد تتماثل في الشئون العبادية الأخرى. فحين يتحدّث الإمام (ع) عن الزهو والتكبر والأحجام عن قضاء الحاجات ( فيما يتصل بسلوك الولاة حيال الرعية )، فإن نفس ظواهر التواضع والاهتمام بحوائج الآخرين يطرحها الإمام (ع) في ( وصاياه ) لخاصة الناس وعوامّهم.
المهم: يعنينا من الملاحظة المتقدمة أن نتجه إلى السمات ( الفنية ) لكلّ من ( الرسائل ) و( الوصايا ) فيما أدرجناهما ضمن ما أسميناه ب- ( الكتاب ) الموجّه إلى مسئولٍ أو غير مسئول.
ويجدر بنا أن نتقدّم بنماذج لكلٍ من النمطين المتقدِّمين، ونبدأ ذلك بالحديث عن:
١ - الرسالة:
قلنا إن ( الرسالة ) صياغة فنيّة خاصة، تُوجّه إلى شخصيّة ذات طابع مسئول، وإن موضوعها - من الغالب - ( محدّد )، يخصّ نمط المسئولية التي يضطلع بها المسئول التي تُوجّه الرسالة إليه، وقد تتسع حيناً إلى آفاق متنوِّعة تتناول مختلف الموضوعات: على نحو ما نلحظه من رسالة الإمام علي (ع) إلى ( الأشتر ) مثلاً، بالقياس إلى الرسائل التي تتناول موضوعاً محدّداً، مثل رسالته (ع) إلى أُمراء الجيش، فيما تحوم على موضوعات عسكرية خاصة.
والمهم أنها تتناول ( موضوعاً محدداً )، موجهاً إلى ( مسؤول )، مصوغاً بشكل ( فنّي ).
نموذج رقم (١):
من رسالة للإمام عليّ (ع) إلى أحد عمّاله، عندما بلغه تراخيه من حمل الناس على الجهاد:
( أما بعد، فقد بلغني عنك قول هو لك وعليك. فإذا قَدِم رسولي عليك: فارفع ذيلك، واشدد مئزرك، واخرج من جُحْرِك، واندب من معك. فإن حقّقت فانفذ، وإنْ تَفَشَّلْت فابعد. وايّم الله لَتُوتيّن حيث أنت، ولا تُترك حتى يُخلط زبدُك بخاثرك، وذائبك بجامدك، وحتى تعجل في قعدتك وتحذر من أمامك كحذرك من خلفك... ).
الرسالة تتناول الحث على الجهاد كما هو واضح، وتتناول نتائجه إيجاباً أو سلباً، من خلال لغة ( العامل ) المُرسَل إليه.
ويعنينا منها: الصياغة الجمالية للرسالة. فبالرغم من أنها تتناول عملية ( حثٍّ ) يتطلّب مجرّد التعبير المباشر، أي غير المصوغ فنّيّاً، إلاّ أنَّه (ع) اتّجه إلى التعبير غير المباشر، فارتكن إلى عنصر ( الصورة ) أو ( الرمز )، حتى ينفذ بدلالاتها إلى ما هو أكثر استثارةً للنفوس.
إننا لو وقفنا عند الصورة ( الاستمرارية )، أي الصورة التي تتركَّب من جملة صور
متتابعة، ونعني بها صورة ( فارفع ذيلك، واشدد مئزرك، واخرج من حجرك )، ومثلها صورة ( حتى يُخلط زبدُك بخاثرك، وذائبك بجامدك )، للحظنا أن تينك الصورتين تتحدَّثان عن موقفين ل- ( الصراع )، لابدَّ أن يختار ( العامل ) أحدهما: فإما أن ينهض إلى الجهاد، وإمّا أن يتراخى عن ذلك. وفي الحالتين تتّجه ( الرسالة ) إلى التعبير ب- ( الصورة ) في تجسيد الصراع المذكور، وترسم نتائجه من خلال كلٍّ من الحثّ أو الابتعاد عن الساحة.
ولعل أبراز ( الصراع ) - في أشدّ حالاته - جسّدته الصورةُ الاستمرارية المتصلةُ، بخلط الزبد بالخاثر والذائب بالجامد.
وأحسبُ - من الزاوية الفنيّة - أن تجسيد ( الصراع ) لا يمكن أن تبلوره - من حيث العمليات النفسية والشدائد التي يواجهها الشخص - بصورة أشدّ عمقاً ووضوحاً من ( الصورة الفنية ) التي رسمها الإمام (ع) في هذا الصدد.
فبالرغم من أن هذه ( الصورة ) تبدو وكأنها ( مألوفة ) زمن التشريع، وأعني بها صورة ( اختلاط خاثر السَّمن برقيقه )، حيث إذا أُوقدت النار لتصفيته يحترق، وإن تُرك بقِيَ كدِراً... أقول: بالرغم من أن التجربة المذكورة تخص بيئةً محدّدة، إلاّ أنها تتجاوز ذلك إلى مطلق الزمن، فتوحي - كما هو شأن الصورة الفنية الناجحة - بمطلق التجارب التي يخلتط فيها ما هو ( خاثر ) بما هو ( رقيق )، سواء أكان سَمناً أم غيره، بخاصة أن الصورة المتقدّمة أردفها الإمام (ع) بصورة أُخرى هي: ( اختلاط الذائب بالجامد )، فهذه الأخيرة لم تُصَغْ لمجرّد التكرار، بل لتكملة أبعاد الصورة الأُولى: حتى يتبلور لدى القارئ مفهوم الصورة بأوضح أطرافها: بصفة أن كل ( ذائب )، مهما كان، حينما يخلط بما هو ( جامد ) لا يأخذ سمة ( الاستقرار )، ممّا يوحي بامتداد عملية ( الصراع ) النفسي الذي ألمح الإمام (ع) إليه.
نموذج رقم (٢):
وحين نتجه إلى رسالة أُخرى للإمام السّجاد (ع)، وجّهها إلى أحد المتعاونين مع السلطة الظالمة، نجد العنصر ( الصوَري ) يأخذ بُعداً آخر من الصياغة، التي تجسّد نمطاً آخر من أشكال العمليات النفسية التي تترتّب على التعاون مع الظالم، ولنقرأ:
( أوليس بدعائه إياك، حين دعاك، جعلوك قطباً أداروا بك رحى مظالمهم، وجسراً يعبرون عليك إلى بلاياهم، وسُلّماً إلى ضلالتهم. داعياً إلى غيّهم، سالكاً سبيلهم... ).
هذه الرسالة تمثّل أيضاً ( موضوعاً ) محدّداً، هو: التعاون مع الظالم. وتوجّه إلى ( شخص ) محدّد، وتُرسم وفق صورة (فنيّة).
وقد اتجه الإمام السجاد (ع) إلى صورة ( مألوفة ) أيضاً، على نحو ما لحظناه عند الإمام عليّ (ع)، هي صورة الرحى والجسر والسُّلّم. وبالرغم من أن الصورة التي لحظناها عند عليّ (ع) كانت أشدّ تكثيفاً من الصورة التي قدّمها السّجاد (ع)، إلاّ أن لكلٍّ منهما وظيفته النفسية في التعبير عن الحقائق. فالصورة التي تكتسب سمة ( النجاح ) في لغة النقد الفني، ينبغي أن تتّسم ب- ( الأُُلفة )، أي: وضوح أطرافها بالنسبة إلى القارئ. وهذه ( الأُلفة ) قد تتشابك بعض أطرافها كما هي الحال بالنسبة إلى الصور التي لحظناها في الرسالة السابقة، وقد تتوضّح بالنحو الذي نلحظه في الصورة التي نتدارسها الآن، وفي الحالين فإن السياق هو الذي يحدِّد نمط ( الأُلفة ): تشابكاً أو وضوحاً.
والآن، حين نعود إلى الصورة المألوفة ( الرحى، الجسر، السُّلّم )، نجدها قد اكتسبت أُلفتها من خلال استخدامها - في مختلف أزمنة الأدب - ( رمزاً ) تراثياً كما هو واضح. والمهم أن الإمام (ع) كان مستهدفاً توضيح الأبعاد المختلفة لعملية التعاون مع الظالم، فجاءت الصورةُ تمثيلاً للعملية المذكورة.
هنا، ينبغي أن ننتبه أيضاً إلى أن ( التكرار ) لصور ثلاثٍ متماثلة، ليست لمجرد ( التكرار )، بل إن استمرارية الصورة بهذا النحو استدعاها الموقف، ( فالرحى ) تمثّل مطلق المفارقات التي يمارسها الأشخاص، دون أن تبرز شخصية ( محددة ) في هذا النطاق. أما ( الجسر )، فيمثّل بروز الشخصية المتقدمة، حيث استُغلّت لتمرير أهدافهم، بملاحظة انسحاق الشخصية. وامَّا ( السلّم )، فيجسّد صعوداً على شخصية مُستغلَّة أيضاً، ولكن بملاحظة ارتفاعها، وليس انسحاقها.
وفي الحالات الثلاث جميعاً، تظل حيال ( شخصية ) مُستَثْمَرةٌ لتمرير المظالم على اختلاف المظاهر، وهذا ما يدلنا على مدى الدقة الفنية في صياغة الصور.
وبعامة: فإن النموذجَين المتقدِّمَين من ( الرسائل )، كانا متناولين لموضوعَين محدَّدَين، مثل الجهاد وعدم التعاون مع الظالم. وقد اكتفينا من العرض لهما ببعض الصياغة الفنية المتصلة بعنصر ( الصورة )، ومساهمتها في تعميق ( الغرض ) الذي تستهدفه الرسالة في الموضوعين المحددَين اللذين أشرنا إليهما.
والأمر نفسه يمكننا ملاحظته في ( الرسائل ) التي تتسم بالطول، وبموضوعات مختلفة، من حيث ارتكانها إلى عنصر ( الصورة ) وسواها من أدوات ( الفنّ ) التي تساهم في تعميق
الهدف.
ومنها - على سبيل المثال - رسالة الإمام علي (ع) إلى ( الأشتر )، فيما لا حاجة إلى الاستشهاد بها ( حيث تناولها الدارسون مفصَّلاً )، عِبْر اشتمالها على موضوعات تتصل بالولاة والعمّال والقضاة والعسكريين والتجار وذوي المهن والكتّاب... إلخ. وقد صيغت وفق لغة متينة مطبوعة بالوضوح واليُسر، وبتوازن الجُمل وتقابلها وبتراوحها الإيقاعي بين الطول والقصر، حسب ما يستدعيه الموقف.
وأهم ما في ذلك أنَّها تشتمل على دلالات فكرية ونفسية لم تقف عند مجرّد ( الإرشاد ) السياسي العام، بل على توشيحه ببطانة عميقة من الفكر، تجمع بين الإرشاد والاستدلال الفكري عليه، وهذا من نحو قولهعليهالسلام :
( وإن ظنّت الرعيّة بك حيفاً، فاصحر لهم بعذرك... ).
إن ( الإصحار ) هنا يمثّل ( صورة فنية )، وليس تعبيراً مباشراً عن إظهار العذر. وأهمية هذه ( الصورة ) التي تتداعى بذهن المتلقِّي إلى ( الخروج إلى الصحراء ) - كما هو المدلول اللغويّ لها. حينئذٍ فإن الوصل بين ( الصحراء )، التي تعني الفسحة والسعة وعدم التحدّد، وبين إبراز ( العذر ) وإظهاره... مثل هذا الوصل بينهما، سيجعل القارئ متداعياً بذهنه بين بروز الصحراء وبروز العذر على نحو ( صوري ) وليس التعبير المباشر.
ولكن الأهم من ذلك هو، الوصل بين الدلالة النفسية لإبراز العذر وبين انعكاسه على استجابة الآخرين. فالعالِم النفسي يقدّر تماماً أهمية العمليات النفسية التي يستجيب لها الشخص من خلال ( إظهار العذر )، بحيث تزاح من أعماقه أية توترات وصراعات يخلّفها عدم الإعلان عن العذر. وهذا يعني أن ( الصورة الفنية - الإصحار بالعذر ) لم تنفصل عن ( العملية النفسية أو الصورة النفسية )، وهو أمرٌ يكسب الشكل الفنّي للرسالة قيمة جديدة كما هو واضح.
وأياً كان، يعنينا ممّا تقدّم أن نخلص إلى القول: بأن ( الرسالة ) ليست مجرّد ممارسة لفظية بتوصيات عامة، بقدر ما هي ( عملٌ فنّي ) تتآزر فيه جملة من العناصر الفكرية والنفسية المصوغة بأدوات الفن: من صورة وإيقاع وبناء هندسي... وما إليها.
أما البناء الهندسي للرسالة، فإن طولها يحتجزنا عن معالجة هذا الجانب. بَيْد أنَّه يكفينا أن نشير إلى أن ( الرسالة ) بدأت بالتوصية بالعمل الصالح، وشدّدت على ( تملك الهوى ) من جانبٍ وعلى ( الرحمة ) للرعيّة من جانب آخر:
( فليكن أحبُّ الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح... فاملك هواك... واشعر قلبك الرحمة للرعية، والمحبة لهم، واللطف بالإحسان إليهم ).
هذا ( التمهيد ) - من حيث البناء الفنّي للرسالة - هو الذي ستحوم عليه كلّ موضوعات ( الرسالة ): من ( تملّكٍ للهوى) في التعامل مع الآخرين، أي سحق
الذات، ومن ( محبة ) للآخرين، أي التوجّه إلى خارج الذات، وهما قطبا السلوك الإنساني في التعامل مع الآخرين. وهذا يعني أن ( الرسالة ) قد انتظمتها عمارة فنيّة تتلاحم فيها الموضوعات على نحوٍ متناسقٍ جمالياً، وليس مجرد موضوعات تتوارد على الخاطر.
٢ - الوصية:
الوصيّة - كما قلنا - تكاد تماثل ( الرسالة ) في بعض أشكالها، سواء أكانت موجَّهة ( على نحو الكتابة ) أو على نحوٍ ( لفظي )، كما لو تقدّم الإمام (ع) بالتوصية اللفظية للشخص بدلاً من الكتابة إليه. إلاّ أنها في الحالتين تبقى مطبوعة بالسمات الموضوعية والفنية التي لحظناها في ( الرسالة )، من حيث تحدّد أو تنوّع موضوعاتها، ومن حيث كونها موجَّهة إلى شخصٍ أو جهة، ومن حيث كونها تعتمد أدوات التعبير الفنّي.
من نماذج ذلك - على سبيل المثال - وصيّة الإمام عليّ (ع) إلى الحسنعليهالسلام :
( من الوالد الفان، المقرّ للزمان، المُدبر العمر، المستسلِم للدهر، الذّام للدنيا... ).
إن هذا الاستهلال يفسح - كما هو بيّن - عن الشكل الأدبي لهذا النمط من الكتابة، إنه: التوصية الموجَّهة إلى شخص هو الحسنعليهالسلام . إلاّ أنها بالرغم من اتسامها بما هو خاص ( التوجّه إلى شخص )، نجدها تتجه - بطريق غير مباشر - إلى عامة الناس. كما نجدها تعنى بمختلف الظواهر العبادية. ويمكننا ملاحظة ذلك في وصلها - منذ البدء - الاستهلالَ بذمِّ الدنيا وإدبار العمر، من خلال التعريف بموقف شخصيته (ع) من الدنيا.
وهذا الاستهلال بتعريف شخصيته (ع) يتضمّن نمطين فنّيّين من صياغة الوصيّة، فمن الحقائق المألوفة ( في حقل العمل الفني ) أنه يجمع بين الخاص والعام، أي: ينطلق الكاتب من قضية ( فردية ) أو ( خاصة )، ليصلها بما هو ( عام )، حتى يُستكمل تمرير الهدف الفكري الذي يَحرص الإمام (ع) توصيله إلى الآخرين. وها هو الإمام (ع) يواصل صياغة ( الوصية ) وفق بناءٍ عماري تتواشج وتتنامى من خلاله: الموضوعات التي انتظمتها الوصيّة، ( فيُفصّل ) ما أجمله في ( التمهيد )، قائلاً:
(أما بعد، فإني فيما بيّنتُ من إدبار الدنيا عنّي، وجموح الدهر عليّ، وإقبال الآخرة إليّ... حتى كأنَّ شيئاً لو أصابك أصابني، وكأنّ الموت لو أتاكَ أتاني، فعناني من أمرك
ما يعنيني من أمر نفسي... ).
في هذا المقطع، ( يفصّل ) الإمام (ع) مُجمل ( التمهيد ) المتصل بإدبار العمر وسواه، واصلاً بين شخصيته (ع) وشخصيّة ولده، من خلال الدافع ( الأبوي )، وهو بدوره يحوم على ما هو ( خاص). بَيْد أنه (ع) يواصل في المقطع الثالث حديثه عن ظواهر عامة، بالرغم من أنها موجَّهة إلى ولدهعليهالسلام ، لكنّها تحوم على تفصيلات أكثر تنوّعاً:
( احي قلبك بالموعظة، وموّته بالزهد، وقوّه باليقين، ونوّره بالحكمة، وذلّله بذكر الموت، وقرّره بالفناء، وبصّره فجائع الدنيا، وحذّره صولة الدهر... ).
فالملاحظ أن المقطع الثالث جاء ( تنميةً عضوية )، أيّ: تطويراً لأفكار بدأت في المقطع الأوّل بمطلق ( فناء العمر )، وأُضيفَ إليها في المقطع الثاني الوصل بين شخصية الأب والابن من حيث انعكاسات ( الفناء ) المذكور. ثم جاء المقطع الثالث ليُفصّل الحديث عن ( الفناء ) وارتباطه بنمط السلوك، الذي ينبغي أن تختّطه الشخصية في تعاملها مع ظواهر الحياة المفضية إلى ( الفناء ). ثم تتوالى المقاطع واحداً بعد الآخر لتتحدّث عن تجارب الحياة والعمر، وصلة ذلك بمحدِّدات السلوك الذي طالب الإمام (ع) بممارسته.
كلّ أولئك يتمّ وفق نماءٍ وتطويرٍ فنّي لأفكار الوصية التي تتواصل أجزاؤها وتتلاحم بعضاً بالآخر ؛ ممّا يكسب النصّ جماليةً فائقة في الهيكل الهندسي له.
وإذا تركنا السمة الفنية المتصلة ب- ( البناء العماري ) للنص، إلى سائر أدوات الفنّ الأخرى، ومنها: عنصر ( الصورة )، لأمكننا ملاحظة هذا العنصر بنحوٍ يساهم - من خلاله - ببلورة المفهومات التي طرحها الإمام (ع) عن الحياة وتجربة العمر والفناء... وما إليها من الموضوعات التي وقفنا عليها في المقاطع المتقدّمة.
من ذلك مثلاً: رسمه (ع) للقلب عملياتٍ خاصة، هي: الإحياء، والأمانة، والقوّة، والتنوير، والتذليل، والتبصير، والتحذير. وهذه الرسوم ليست مجرّد عرض عابر، بقدر ما تشكّل ( صوراً فنيّة )، بالرغم من أنها لم تأخذ شكل الصورة التركيبية ذات البُعد ( الرمزي ) المكثَّف، بل أخذت شكلاً مألوفاً سهلاً، إلاّ أنها خضعت لمبدأ فنّي هو: ( التضاد ) و( التماثل ).
( فالتضاد من خلال التماثل ) يشكِّل - في لغة النقد الفنّي - واحداً من أشكال الصياغة المعاصرة لأشكال الفن. (التضاد) هنا بين ( إحياء ) القلب و( إماتته )، ولكن من خلال ( التشابه ) الذي يجسّد مفهوم ( المعرفة ) العبادية. كما أن ( التباين ): من ( تقوية ) و( تنوير ) و( تذليل )، من خلال ( التشابه ) المذكور، يجسّد نفس الفاعليّة الفنيّة
من حيث استتارة النفوس، مادمنا نعرف - من حيث الاستجابة الفنية ( وهذا ما انتبه إليه مؤخراً علماء النفس الجشطالتيون ) أن الشخصيّة تستجيب لأيّ منبّه، من خلال ( الكلّ ) أو ( الوحدة ) التي تنتظم مختلف الجزئيات في ( شكل موحّد ).
( المقال... ):
المقال الأدبي يتناول موضوعاً محدّداً، تُلقى عليه مختلفُ الأضواء ذات الصلة بالموضوع، ويتميّز عن المقال ( العلمي ) بكونه يُعنى بانتقاء المفردة والتركيب، كما يُعنى - إلى حدٍ ما - بعنصري الصورة والإيقاع، لكن دون أن يتحوّل إلى عمل إنشائي صرف، فهو لا يحمل ( جفاف ) التعبير العلمي، كما لا يحمل طابع ( الإنشاء ) الفنّي، بل تطبعه سمة ( العلم ) مصطبغاً بسمة ( الفن ).
إنه يختلف عن كلٍ من الخطبة والخاطرة والرسالة والدعاء.. وسواها، بكونه لا يُعنى بالبُعد ( العاطفي )، ولا يُوجَّه إلى شخصٍ أو جهةٍ محددّة، ولا تتوزّعه موضوعات شتى، ولا يُثَقل بأدوات الصياغة الجمالية إِلاّ عابراً. ويمكننا أن نجده في بعض نماذجه مماثلاً ( للخاطرة ) من حيث تناوله ظواهر سريعة، إلاّ أنه متميّز عنها بكونه يتناول ظاهرة ( فكرية ) وليس مجرد انطباع عابر، كما يتميّز عنها بكبر الحجم الذي ينتظم موضوعه.
وإليك بعض النماذج ذات الصلة بالخاطرة:
نموذج (١):
من النماذج التي تندرج ضمن ( المقال ) الفني، ما كتبه الإمام السجاد (ع) عن ( الزهد ) مثلاً، حيث حام المقال على موضوع محدّد، هو ( الزهد )، جاء فيه:
( كأنّ المبتلى بحب الدنيا به خبل من سكر الشراب. وإن العاقل عن الله، الخائف منه، العامل له، ليمرّن نفسه ويعودها الجوع حتى ما تشتاق إلى الشبع، وكذلك تضمر الخيل لسباق الرهان... ).
هذا المقطع، حافلٌ - كما هو ملاحظ - بأدوات الصياغة الجمالية، بخاصة عنصر ( الصورة )، مِن نحو تشبيه المعنيّ بحب الدنيا بمَن فيه خبل من سكر الشراب، ونحو تمثيله
لِمَن درَّب نفسه على الجوع بالخيل الضّمير في ميدان السباق. ولا يخفى أن تركيب العبارة وانتقاء المفردة يشعّان بليونةٍ لفظية وبإشراق صوتي وبأنسابية عامة، ممّا يُدخل المقال في صميم العمل الفني الخالص، كما يماثل ( الخاطرة ) في سمته الانطباعية.
ويمكننا أن نقدّم نموذجاً آخر للإمام الرضا (ع) في مقالته عن الإمامة، جاء فيها:
نموذج (٢):
( الإمام: كالشمس الطالعة المجلِّلة بنورها للعالم، وهو بالأُفق حيث لا تناله الأبصار ولا الأيدي.
الإمام: البدر المنير، والسراج الزاهر، والنور الطالع، والنجم الهادي في غيابات الرحى، والدليل على الهدى، والمنجي من الردى.
الإمام: النار على اليفاع، الحار لمن اصطلى، والدليل في المهالك... ).
هذا المقطع - كما هو بيّنٌ - صياغة فنيّة مثل سابقتها، اتكاءً على عنصر الصورة وجمال العبارة. وهي وسابقتها إلى لغة ( الفن ) أقرب منهما إلى لغة ( العلم )، وإلى( الانطباعية ) أقرب منها إلى مجرد التعبير عن الحقائق.
وهكذا حين نتجه إلى ما كتبه الإمام عليّ (ع) في مقالته عن ( المتقين ):
نموذج (٣):
( لولا الآجال التي كتب الله لهم، لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين ؛ شوقاً إلى الثواب وخوفاً من العقاب. عَظُمَ الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم، فهم والجنَّةُ كمَن قد رآها فهم فيها مُنَعَّمُون، وهم والنَّارُ كمن قد رآها فهم فيها مُعَذَّبُون. قلوبهم محزونة وشرورهم مأمونة، وأجسادهم نحيفة، وحاجاتهم خفيفة، وأنفسهم عفيفة... ).
هذا النموذج مثل النموذجين السابقين من حيث ارتكانه إلى أدوات الصورة والإيقاع والانطباعية. بَيْد أن الملاحظ فيها جميعاً أنها تناولت السمات العامة للشخصية، مثل: الزاهد والإمام والمتّقي، أي أن غلبة العنصر ( الانطباعي ) فيها مرتبط بطبيعة التناول الذي يستجرّ معه أمثلة الأسلوب المذكور.
إنها تماثل رسم ( القاص ) لأبطاله، حيث يرسمهم فرديين وجمعيين، موسومين بملامح
خارجية وداخلية وفق ( انطباعية ) عامة عن معرفته بسلوكهم. هنا يتجه الرسم إلى أبطال جمعيين نموذجيين، يصف ملامحهم الداخلية ( والخارجية أيضاً )، مثل: أجسامهم نحيفة، عمش العيون، خمص البطون... إلخ.
إذن يمكننا أن نشطر ( المقال ) إلى أكثر من ضرب تعبيري، بعضه إلى ( الخاطرة ) أقرب منه إلى مطلق التعبير المباشر، وبعضه يتجه إلى ( الرسم القصصي ) أكثر منه إلى رسم آخر، وبعضه الثالث يتجه إلى السمة العامة ( للمقال )، ونعني بها: السمة المتمثِّلة في تطبيعه ب- ( العلم ) مصطبغاً ب- ( الفن )، وهذا ما نقدِّم له نموذجاً أيضاً.
نموذج (٤):
قال الإمام علي (ع) في مقال له عن أصل الإبداع الكوني والبشري:
( أنشأ الخلق انشاء، وابتدأه ابتداء، بلا روية آجالها، ولا تجربة استفادها، ولا حركةٍ أحدثها، ولا هَمَامَةِ نفسٍ اضطرب فيها. أحال الأشياء لأوقاتها، ولَأَمَ بين مختلفاتها، وغَرَّزَ غرائزها، وألزمها أشباحها. عالماً بها قبل ابتدائها، محيطاً بحدودها وانتهائها، عارفاً بقرائنها وأَحْنَائِهَا... ).
فالإمام (ع) في صدد الظواهر الإبداعية، وهو رصدٌ علمي لأصولها، لا يكاد التعبير غير المباشر يتخلَّل الرصد المذكور بقدر ما تتخلّله قيم صوتية ( قرار وتوازن بين الجُمَل ).
الخاطرة...:
تجسّد ( الخاطرةُ ) - في حقل الأدب - ( إحساساً ) مفرداً حيال أحد الموضوعات. ونقصد ب- ( الإحساس المفرد ) ما يقابل ( الفكر المركّب )، فيما يتناول موضوعات ذات طابع تفصيلي يعتمد أدوات الفكر الاستدلالي في صياغة الشكل الفني. وهذا بعكس ( الخاطرة ) التي تعني مجرّد ( إحساس ) يتّسم بالتأمل السريع لإحدى الظواهر، مع تسليط ضوءٍ فكري مركّز عليه، وحصْرِها في نطاق محدد من التناول.
أما ( هيكل ) الخاطرة، فيصاغ وفق عبارة قصيرة مصوِّرة جميلة، أي: ذات انتقاءٍ صوتي ( إيقاعي ) من حيث تجانس وتآلف الحرف والمفردة والفقرة، وذات عنصر ( تخيّلي ) يعتمد الصورة أو المأثور اليومي، تعبيراً عن الإحساس الذي تقوم عليه ( الخاطرة ). إنها - في هذا الصدد - لا تختلف عن سائر أشكال التعبير الفنّي، من حيث اعتمادها عنصر ( الصوت ) و( الصورة ) و( البناء ) أساساً لهيكلها الفنّي.
بَيْد أنَّها تتميّز بكونها ( إِحساساً سريعاً ) حول أحد الموضوعات، حيث تستتلي سرعة هذا الإحساس شكلاً فنيّاً يقوم على حجم صغير من التناول، وعبارة قصيرة أو متلاحقة، مفعمة بالتساؤل والاستطلاع، أو السرد والعرض المجرّدين لهذا الإحساس أو ذاك.
وأهمية هذا الشكل الفني تتمثّل في كونها تتساوق مع حركة الإنسان، التي تواجه يومياً أكثر من ظاهرة أمامها عبْر ممارستها أحد الأعمال، فقد يستوقفها حادث اصطدام، أو مرور جنازة، أو مصافحة بين صديقين، أو أذان المسجد، أو رائحة شواء، أو صراخ الباعة، أو مجرد سماعها لنبأ أو مشاهدتها لظاهرة كونية... أمثلة هذه ( المواجهة ) العابرة التي تخطف كلاً منّا يومياً، تقترن - كما هو واضح - بإحساسٍ عابر، وتتطلّب - كما هو واضح أيضاً - حجماً قصيراً لا يتجاوز الأسطر، وشكلاً فنياً متطابقاً مع تموجّات الإحساس الذي تستثيره مثل هذه المواجهة.
ولا يخفى أيضاً أن لظهور الصحافة في العصور الحديثة أثره في حمل الكتّاب
على ممارسة هذا اللون من الكتابة، التي تحتل جانباً صغيراً من ( أعمدة ) الصحيفة أو المجلة. بَيْد أن هذا يشكّل مجرد باعث لانتشارها وليس لكاتبها بعامة ؛ ولذلك فلا يكاد يخلو عصر من عصور الأدب من أمثلة هذه ( الخواطر ) التي يمارسها الكتّاب قديماً وحديثاً.
المهم، يعنينا أن نعرض بعض ( النماذج ) التي ألِفَها الأدب التشريعي في هذا الصدد، ولنقرأ هذه الخاطرة السريعة للإمام الحسن (ع) في وصف أخٍ صالحٍ له:
( كان من أعظم الناس في عيني. وكان رأس ما عظمَ به في عيني صغر الدنيا في عَينِه. كان لا يشتكي ولا يتبرّم. كان أكثر دهره صامتاً، فإذا قال، بذَّ القائلين. كان إذا جالس العلماء على أن يسمع أحرص منه على أن يقول، وإذا غُلب على الكلام لم يُغلب على السكوت. لا يقول ما لا يفعل ويفعل ما لا يقول. وإذا عرض له أمران لا يدري أيّهما أقرب إلى ربّه، نظر أقربهما إلى هواه فخالفه. لا يلوم أحداً على ما قد يقع العذر فيه ).
إن هذه الخاطرة تشمل في واقعها مجموعة ( أحاديث ) نجدها منتثرةً هنا وهناك، غير أن ما يميزها هو: تطبيق مضمونها الذي يُشكّل توصيات لسمات أخلاقية معيّنة، خلعها الإمام الحسن (ع) على أحد إخوانه. وقد اكتسبت طابعاً فنياً يميّزها عن مجرد الحديث ؛ نظراً لتمركزها حول شخص محدّد أملاه موقف عابر يتصل بالشخص المذكور، فجاءت ( خاطرة ) تحوم على ( سمات ) لحظها الإمام (ع) متوفّرة لدى الشخص.
ولعل أول ما يلفت انتباهنا من الخاطرة المذكورة، هو ( واقعيتها ) أو ( حقيقيتها ) التي لا نألف مماثلاً لها في الأدب الأرضي. فالشعراء أو الكتّاب ( في حقل المراثي أو المدائح - على سبيل المثال ) لا يكادون يتناولون ميتاً بالرثاء، أو حيّاً بالمدح، إلاّ وتجد ( المبالغة ) المقيتة طابعاً لنتاجهم، فالشمس والقمر، والجبل والجو، والبر والبحر والشجَر، تصبح عرضة للكسوف والخسوف، والزلزال والإعصار، والخسف والجفاف والْيَبْس نتيجة لموت أحد الأشخاص، أو أن كلاًّ من الظواهر الكونية المذكورة تقف منحسرةً أمام عظمة الشخص وسخائه مثلاً....
الإمام (ع) لم يصُغْ أية حقيقة لدى الشخص المذكور، خارجة عن سماته الموجودة فعلاً لديه، فأشار إلى زهده وعدم شكواه، وصمته وتسامحه...، دون أن يضيف إليها أو ينتقص منها شيئاً. كل ما في الأمر أن إشارته (ع) للسمات المذكورة صيغت وفق لغة ( فنية ) تتطلّبها الحقيقة ذاتها من حيث انعكاساتها في ذهن الكاتب والمتلقّي، وهذا ما يقودنا - ولو سريعاً - إلى توضيح بعض القيم الفنية للخاطرة المذكورة.
أول ما يطالعنا في هذه الخاطرة عنصر ( التقابل ) الذي يشكّل أحد مكوّنات ( الصورة الفنية )، كما يُطالعنا أحد أشكال الصورة متمثّلاً في ( الرمز ).
ويمكننا ملاحظة هذين العنصرين في الفقرة التالية:
( وكان رأس ما عظم به في عيني: صغر الدنيا في عينه ).
إنّ أهمية هذه الفقرة تتجسّد في انطوائها على الصورة الاستمرارية أو المركّبة، أي تعاقب الصور فيها وتداخلها فيما بينها. فثَمَّة صورة هي ( صغر الدنيا في عينه ) تقابلها صورة ( رأس ما عظم به في عيني ). ونفس ( التقابل ) - بصورتيه: العظمة والصغر - يشكّل ( صورة ) لها استقلاليتها وإثارتها الفنية.
مضافاً إلى ذلك - من حيث البناء الفني لمجموع الصور - أنّ استهلال الخاطرة بالصورة القائلة: كان من أعظم الناس في عيني. يجسّد تمهيداً، أو موقفاً مُجملاً، يتقدّم النصُّ بعد ذلك بتفصيله الذي اضطلعت به الصورتان المتقابلتان، أي أنّ التعليل الفنّي للحقيقة القائلة بأنَّ الأخ المذكور كان من أعظم الناس في عينه، إنما كان - في الدرجة الرئيسة - لصغر الدنيا في عين الأخ. بكلمة أخرى: جاء عنصر ( التقابل ) جواباً فنيّاً يفصّل ( التمهيد ) الذي استهلت به الخاطرة.
ولا يخفى مدى انطواء هذا النمط من ( بناء الصور ) وتداخلها وتواشجها العضوي، الذي يُنمّي أفكار الخاطرة من خلال التمهيد وتفصيله، لا يخفى ما لهذا النمط العماري من إثارة فنيّة قد يجهلها القارئ العابر، إلاّ أن الناقد الذي يمتلك حسّاً تذوقياً، يقدّر خطورة الإثارة التي يستجيب لها وفاقاً لمنطق البناء المذكور.
وإذا ذهبنا نتابع سائر مقاطع الخاطرة، لحظنا أن عنصر الصورة المتمثل في ( التقابل )، يكاد يشكّل البطانة أو العصب الفنّي للخاطرة:
فهناك ( الصمت ) يقابله ( القول): ( كان أكثر دهره صامتاً، فإذا قال، بذّ القائلين ).
وهناك ( الاستماع ) يقابله ( القول ) أيضاً: ( على أنْ يسمع أحرص منه على أن يقول ).
وهناك ( الفعل ) يقابله ( القول ) أيضاً: ( لا يقول ما لا يفعل، ويفعل ما لا يقول ).
ولا نغفل أن ( التقابل ) الأخير ينطوي على عنصرين من التقابل: أحدهما: القول والفعل، والآخر: ( لا ) و( و ) ( لا يقول - ويفعل )، هذا إلى أن ( تقابلاً ) متكرراً أخذ موقعه العضوي من الخاطرة، متمثَّلاً في ( إذا غُلب على الكلام لم يُغلب على السكوت ).
إن هذا الحشد الضخم، المتعاقب، المتداخل، المتكرر، المتجانس: من ( التقابل ) بين ( القول والفعل )، وصياغته وفق منحنيات متعددة من الطرح، يشكّل عملاً فنيّاً ضخماً له قدراته التوصيلية، التي لا يستكنه قيمتها إِلاّ مَن خبر طرائق الاستجابة في السلوك البشري وتحديد مواطن الإثارة منها.
بَيْد إن أهم ما يلفت الانتباه في هذا الصدد، هو: أن عنصر ( التقابل ) بشكله المتجانس ( الصمت والقول والفعل ) - حيث انصبّ هيكل الخاطرة على المفردات الثلاث المذكورة - إنما صيغ ببساطة ويسر وسهولة، يظن القارئ من خلالها أنه حيال مجرد أحاديث عن مجالسة العلماء واختيار الصمت واقتران القول بالعمل... لا أنَّه حيال شكل فنّيّ صيغ وفقاً لسمات خاصة، لها أسرارُها في عملية التذوق وتعميق الدلالة التي يستهدفها الإمام (ع) من الخاطرة المذكورة.
أخيراً ينبغي أن نعرف أن صياغة الأفكار المذكورة وفقاً لقيمٍ فنية خاصة، إِنَّما توكّأت على عنصر ( الفن )، فلأن هذا الأخير يساهم في بلورة وتركيز ( القيمة الفكرية ) للخاطرة، ممّا يعني أن ( الأفكار ) المستهدفة في الخاطرة، ينبغي أن نتمثَّلها عملياً في سلوكنا اليومي، مادام ( الفن ) مجرد وسيلة لمعرفة الوظيفة العبادية.
إذن، لنلخّص ( أفكار ) الخاطرة، ونعرضها على واجهة أعمالنا التي نعتزم ممارستها من خلال الوظيفة العبادية.
وها هي الخاطرة تقول:
١ - لتكن الدنيا صغيرةً في عينك.
٢ - لا تشك ولا تتبرّم.
٣ - اختر الصمت على الكلام.
٤ - تكلّم بجدية وعلم إذا كان الأمر مستدعياً لذلك.
٥ - إذا ضمك مجلس العلم، فاحرص على الاستماع لا الكلام.
٦ - لم تخسر شيئاً بسبب الصمت، ولكنَّه قد تخسر شيئاً بسبب الكلام.
٧ - كن على العمل أحرص منك على القول.
٨ - مارس عملية ( تأجيل ) لشهواتك.
٩ - لا تعاتب أحداً وأنت تجد له موضعاً لإمكانية العذر.
أن هذه التوصيات التسع التي تضمنتها ( الخاطرة ) السريعة، حينما نعرضها على اللغة النفسية التي اخترناها إلى جانب اللغة الفنية في دراستنا للفن التشريعي، نجدها تتناول
جملة من الحقائق - أو لِنَقُلْ : جملة من العمليات النفسية - وهي:
١ - الزهد.
٢ - التسامح.
٣ - الصبر.
٤ - الصمت.
( فالزاهد ) لا يُعنى بأية حاجة دنيوية تستتلي التوتر والانشطار نتيجة لعدم إشباع الحاجة المذكورة.
( المتسامح ) لا يسمح لذاته بأن تُنمى لديها أية نزعة عدوانية، فيربح بذلك توازناً داخلياً ملحوظاً، بعكس النزعة الحاقدة التي تقترن بتوتر الأعماق وصراعاتها.
و( الصابر ) يوفر لنفسه التوازن المذكور، بعكس ( الجازع ) الذي يرشّح شخصيته للوقوع في هاوية أكثر من مرض.
أما ( الصامت )، فيكفيه أنه يدرّب شخصيته على ( وأد الذات )، ولا يسمح لها بالتورُّم والتمركز حول الذات، حيث تمزّق إحباطات الحياة المختلفة كل تطلّعات الذات المريضة، وتساهم في تعميق مرضها.
الدعاء
١ - السمات العامة:
الدعاء - كما نعرف جميعاً - يُعدّ نوعاً من الممارسة الوجدانية حيال ( الله ) تعالى... ويفترق عن سائر ألوان التعبير الفنّي بكونه يجسّد ( تجربة ) داخلية تتواصل مع ( الله ) مباشرةً... كلّ ما في الأمر أن ( التجربة ) المذكورة لم تخضع لصياغة (الداعي )، بل للصياغة الشرعية. بكلمة جديدة: المشرّع الإسلامي هو الذي يتكفّل بصياغة ( تجربة ) الداعي، ويقدّمها له ل- ( يتمثَّلها ) هذا الأخير وكأنَّها من نتاج ذاته.
من هنا يفترق ( الدعاء ) عن سائر الفنون التعبيرية الأخرى بكونه ( تجربة داخليّة )، لا أنّها ( أفكار منقولة ) إلى الشخص، كما هو شأن الخطبة والرسالة والخاطرة وغيرها من أشكال الفنّ، التي تتكفّل بعملية ( نقل ) للمواقف بنحوٍ يكون كلٌ منّا مجرّد ( متلّقٍ ) حيالها، في حين أن ( الدعاء ) يحوّل كلاًّ منّا - مضافاً لِما تقدّم - إلى ( مُنشي ) وجداني في توجّهنا بالكلام إلى الله.
ويترتّب على هذا الفارق بين ( الدعاء ) وغيره، أن تتمّ صياغته بنحوٍ لا تتجاوز تجربة الشخص من حيث انفعالاته بالمواقف، سواء أكانت هذه المواقف ( فردية ) أم ( اجتماعية ) أم ( موضوعية ) صرفاً.
والمقصود بالمواقف ( الفردية): الحاجات النفسية والحيويّة التي يتطلّع الداعي إلى تحقيقها بالنسبة ل- ( ذاته ).
أما المواقف ( الاجتماعية )، فيُقصدُ بها دعاء الشخص ( للآخرين ) وتطلّعه إلى تحقيق إشباع حاجاتهم المختلفة.
ولعله يمكن القول بأن ( الدعاء ) - بخلاف سائر الفنون التعبيرية - يحقّق، من حيث عمليات التعديل للسلوك، ممارسة مباشرة للتعديل المتّصل بسلوكنا نحو ( الآخرين )، أو ما يُطلق عليه ب- ( الغيريّة ) أو ( الإيثار )، حيث ( يدرّبنا ) - كما سنلحظ في النماذج التي
سنقدّمها - على أن نُعنى بالآخرين قبل أن نتجه إلى ( ذواتنا )، وهذا ما يجعل ( الدعاء ) بمثابة ( تطبيق ) للمبادئ التي تُطالبنا ( السماءُ ) بها في نصوص الأدب التشريعي التي تقدّم الحديثُ عنها.
وأما المواقف ( الموضوعية ) الصرف، فيُقصد بها: التعامل مع المبادئ بنحوٍ عام، بغض النظر عن فائدتها ( الذاتية )، مثل: التعامل مع حقائق الله أو ظواهره الإبداعية، أو التعامل أهل البيتعليهمالسلام ... وفي الحالات جميعاً لا يضمر حجم التعامل ( الوجداني ) لدى الداعي إلاّ من حيث انسلاله من دائرة الحاجات ( الفردية )، والتوجه بذلك إلى الحاجات ( العقلية ).
ومن الواضح - في حقل العمليات النفسية - أن الكائن الآدمي تتوزّعه ثلاث حاجات، يحقق كلٌّ منها إِشباعاً لشخصيته، وهي:
١ - الحاجات النفسية، مثل: التقدير والحبّ ونحوهما، بما في ذلك محبته للآخرين أيضاً.
٢ - الحاجات الحيوية، مثل: الطعام، النوم... إلخ.
٣ - الحاجات العقلية، مثل: استكناه الحقائق وتقويمها، بغضّ النظر عن فائدتها ( الذاتية ) كما قلنا.
وطبيعياً، أن ينتسب النمط الثالث من الحاجات إلى ما أسميناه ب- ( المواقف الموضوعية ) المتصلة بالتعامل مع الله، وظواهره الإبداعية، والمصطفين من الآدميين.
المهمّ، يظلّ ( البُعد الوجداني ) هو البطانة العامة لأدب الدعاء، بما في ذلك النمط ( الموضوعي ) منه ؛ بصفة أن الداعي (ينفعل ) بالحقائق الموضوعية التي يتّجه بالدعاء من خلالها.
وفي ضوء ما تقدم يمكننا أن نقرّر بوضوح، بأنَّ الصياغة الفنيّة للدعاء تتحدّد وفقاً للأسس التي ألمحنا إليها، مضافاً لأدوات الشكل الجمالي: صوت، صورة، بناء، طرافة....
وإذا كانت الأسس المذكورة من الممكن أن تتجسّد في نصٍّ محدّد حيناً، أو أقلّ منها، إلاّ أنّ خصائص كلٍّ من ( البُعد الوجداني ) و( الموضوعي ) و( الفنّي ) تظلّ عصباً رئيساً يتسرَّب في الأدعية جميعاً، سواء أكانت ذات طابع فردي أم اجتماعي أم عقلي.
ويمكننا - على سبيل المثال - أن نأخذ الدعاء التالي لملاحظة السمات الثلاث التي أشرنا إليها:
( اللّهم إنِّي أعتذر إليك من مظلوم ظُلِمَ بحضرتي فلم أَنْصُرْه، ومن معروفٍ أُسدِيَ إليَّ فلم أشكُرْه، ومن مسيءٍ اعتذر إليَّ فلم أعذُرْه، ومن ذي فاقة سألني فلم أوثرْه، ومن حق ذي حقٍّ لزمني لمؤمنٍ فلم أوفِّر، ومن عيب مؤمن ظهر لي فلم أسترْه، ومن كلِّ إِثمٍ عرضَ لي فلم أهجرْه. أعتذر اعتذراً إليك - إِلهي - منهنّ ومن نظائرهنّ: اعتذار ندامة تكون واعظاً لما بين يديّ من أشباههن. فصلّ على محمدٍ وآله، واجعل ندامتي على ما وقعتُ فيه من الزلاَّت، وعزمي على ما يعرض لي من السيِّئات، توبةً توجب لي محبّتك، يا محبّ التوّابين ).
إن هذا النصّ - على قصره - يتضمّن ( البُعد الوجداني ) المتمثّل في كلّ من: ( الاعتذار )، ( الندامة )، ( العزم على الترك ). ولا يخفى أن كلّ واحدة من المفردات الثلاث يجسّد عمليةً نفسيّة ذات طابع ( انفعالي ). فالاعتذار: إِفصاحٌ عن حالة داخلية ذات طابع ( متوتّر )، و( الندامة): انكسارٌ نفسي يجيء نتيجة لتوتّرات بالغة الحدّة. و( العزم على الترك): انفعال حادٌ على ( تصميم ) شيءٍ ما...
إذن: ( البُعد الوجداني ) واضحٌ كلّ الوضوح في هذا النصّ.
أما ( البُعد الفنّي ) في النص، فيتمثّل في أوضح أدواته في ( القرار الإيقاعي )، من نحو: أنصره، أشكره، أعذره، أوثره، أوفره، أستره، أهجره... كما يتمثّل في ( توازن ) العبارات هندسياً، من حيث توازن عدد المفردات في كلّ فقرة مع سائر الفقرات المنتهية بالقرار الإيقاعي المذكور، وهو أمر يلحظه المتلقّي - من حيث جمالية الجرس المذكور - بنحوٍ مُدهش دون أدنى شك.
وأخيراً: ( البُعد الموضوعي )، متمثّلاً في الصلاةً على محمّد وآله، كما لحظنا ذلك في الفقرات الأخيرة من الدعاء المذكور.
ويُلاحَظ: أن ما أسميناه ب- ( البُعد الموضوعي ) يتخلَّل الأدعية جميعاً، من حيث ( الآداب ) التي يصوغها المشرّع الإسلامي في ممارسة ( الدعاء )، وإلاّ فإن ( موضوعية ) الدعاء تشكّل - كما قلنا - واحداً من أنماط ثلاثة، هي: ( الحاجات الفردية ) و( الاجتماعية ) و( العقلية )، حيث ينتسب ( الدعاء الموضوعي ) إلى الأخير منها.
ولعل السّرّ الكامن وراء هذه ( الآداب ) يتمثّل في: نقل الداعي من ( همومه الذاتية ) إلى الهموم الموضوعية ؛ ليستكمل بذلك شخصيته ذات الطابع السويّ، وإلاّ فإن التأكيد على ما هو ( فرديّ ) فحسب يظلّ - كما هو معروفٌ في لغة علم النفس المَرَضي - من أبرز معالم الشخصية الشاذّة. ولذلك يُحاول ( الدعاء ) - بصفته واحداً من أشكال التعبير الفني الهادف - أن يدفع بالشخصية إلى ( تعديل ) سلوكها، من خلال مزج ما هو ( ذاتي ) بما هو
( موضوعي) كما مرّت الإشارة إليه فيما يتّصل ب- ( الغيرية ). والأمر نفسه فيما يتصل بموضوعيته من حيث الثناء على الله، والتوجّه نحو ظواهره الإبداعية، والتوجه نحو أهل البيتعليهالسلام .
من هنا نلحظ أن غالبية نصوص الدعاء تبدأ بالثناء على الله أو الصلاة على محمد وآله، أو يختتم الدعاء بهما، أو بأيِّة عبارة أُخرى تتضمّن إحدى صفاته تعالى... أو أن الداعي نفسه - وفقاً للآداب المذكورة - يبدأ استهلال الدعاء أو اختتامه بذلك، في حالة ما إذا أنشأ الدعاء بنفسه.
المهمّ، أن موضوعية الدعاء تظلّ أبرز المعالم في هذا الصدد، حتى إن بعض النصوص تأخذ مبنىً هندسيّاً قائماً على ( السمة الفنيّة ) المذكورة، من خلال عمليات البناء الفكري للنص: في تعدد موضوعاته مثلاً، وتنامي مواقفه متمثلاً في وصل كلّ موضوعٍ بآخر، وتناميه: عن طريق ( الحمد ) أو ( الصلاة ).
ولعل أوضح نموذجٍ في هذا الصدد هو " دعاء مكارم الأخلاق "، فيما يتضمن عشرين مقطعاً، كلّ واحدٍ منها يتناول موضوعاً محدّداً، وكلّ موضوع تنتظمه جملة من المفردات، تُستهلّ بفقرة ( اللهم صلّ على محمد وآل محمد ) ؛ تدليلاً على السمة ( الموضوعية ) التي أشرنا إليها من جانب، وعلى السمة ( الهندسية ) التي يتطلّبها الانتقال من موضوع لآخر، ووصلها برباطٍ فكريّ يوحّد بين أجزائها من جانبٍ آخر.
ولنقرأ - على سبيل النموذج - قسماً من النصّ:
( اللّهم صلّ على محمد وآله: وبلّغ بإيماني أكمل الإيمان، وبيقيني...
اللّهم صلّ على محمد وآله: واكفني ما يشغلني الاهتمام به...
اللّهم صلّ على محمد وآله: ولا ترفعني في الناس درجةً إلاّ...
اللّهم صلّ على محمد وآله: ومتّعني بهدىً صالحٍ لا أستبدل به...
اللّهم صلّ على محمد وآله: وأبدلني من بغضة أهل الشنآن المحبة...
اللّهم صلّ على محمد وآله: واجعل لي يداً على مَن ظلمني... ).
إن هذا ( الدعاء ) الذي يشكّل ( وثيقة نفسية ) من حيث تضمّنه لمبادئ السلوك الصحّي، مصوغٌ وفق عمارة هندسية بالغة الدهشة: بدءاً من مقطعه الأوّل الذي يشكّل ( تمهيداً) تفصّله المقاطع الأخرى، مروراً بمقاطعه المتلاحمة عضويّاً، وانتهاءً بمفردات كلّ مقطع منها وتلاحم هذه المفردات فيما بينها أيضاً، وهو أمرٌ لا تسمح به دراستنا الأدبية
السريعة بتناوله مفصّلاً.
المهمّ أن نشير فحسب، إلى أن فقرة ( اللّهم صلّ على محمد وآل محمد ) وُظِفَت فنيّاً بحيث شكّلت نقلةً فنية من ( الذات ) إلى ( الموضوع ) من جانب، وأداة وصلٍ وتلاحمٍ بين الموضوعات من جانب آخر.
هذا كلّه: في حالة ما إذا كان الداعي في صدد حاجاته الفرديّة.
أما إذا كان في صدد المواقف العقلية مثلاً، أي استكناهه لحقائق الله وظواهره الإبداعية، أو المواقف الغيرية أيضاً، حينئذٍ فإن هذا النمط من التعامل يشكّل نوعاً مستقلاً من أدب الدعاء: له سماته الخاصة التي تميّزه عن أنواع الدعاء.
وهذا ما نحاول أن نعرض له الآن...
* * *
٢ - السمة الموضوعية والفردية:
إن السمة المميّزة للدعاء الموضوعي، هي: خلوّ الدعاء من الحاجات الفردية وانصرافه إلى الحاجات العقلية الخالصة، متمثلةً في المقولة المعروفة لعليّعليهالسلام في ذهابه إلى أنَّهعليهالسلام لم يعبد الله طمعاً في الجنة أو هرباً من النار بقدر ما وجده ( تعالى ) أهلاً لذلك.
طبيعياً، أن يتّسم هذا النمط من الدعاء بأرفع العمليات النفسية، من حيث نبذها لأيّة شائبة من الذات، وأن ممارسته تُعدّ ( تدريباً ) على ( الاستواء ) في السلوك في أعلى تصوّرٍ له.
ولعل أوضح نماذجه، يتمثّل في دعاء "العشرات " المعروف، وفي نصوصٍ من "الصحيفة السجَّادية " وغيرها.
ويمكن تصنيف هذا النمط من الأدعية - كما أشرنا - إلى ما يتصل بصفات الله، وظواهره الإبداعية، وأصفيائه من الآدميين. كما يمكن إضافة ( المواقف الغيرية ) إليه أيضاً، مادامت مبتعدة عن دائرة ( الذات ) أيضاً. وهذا جميعاً ما يمكن ملاحظته في أدعية ( الصحيفة السجادية )، مثل دعائهعليهالسلام : ( التحميد لله عزّ وجلّ )، و( الصلاة على حملة العرش )، و( دعائه لجيرانه وأوليائه )، و( أهل البيتعليهمالسلام .
طبيعياً أيضاً أن ( الحاجات الفردية ) من الممكن أن تتخلّل أمثلة هذه الأدعية، إلاّ أنها تظلّ عابرة أو ثانوية بالقياس إلى الطابع الموضوعي للدعاء. فلو وقفنا على الدعاء الأول
من الصحيفة السجادية، للحظنا أن مقاطعه جميعاً تمضي على النحو التالي الذي استُهلّ به الدعاء:
( الحمد لله الأوّل بلا أوّل كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده. الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. ابتدع بقدرته الخلق ابتداعاً، واخترعهم على مشيته اختراعاً.. ).
ثم تجيء فقرة عابرة في تضاعيف الحمد على هذا النحو:
( حمداً تقرّ به عيوننا إذا برقت الأبصار، وتبيّض به وجوهنا إذا اسودت الأبشار. حمداً نُعتَق به من أليم نار الله، إلى كريم جوار الله... ).، فهذه الفقرة تفصح عن حاجة ( فردية )، إِلاّ أنها ليست متصلة بالحياة الدنيا ومتاعها، بل بحاجات (أخروية)، مستهدَفةً عبادياً دون أدنى شك.
ومهما يكن، فإن السمة الموضوعية للدعاء، يمكن تحديدها في مستويات متنوعة، بعضها: يتصل بما هو ( عقليٌ صرف )، وبعضها بما هو ( أخروي )، وبعضها بما هو ( غيري)، على تفاوت في ذلك.
أما السمة ( الفردية )، فتتمثّل في جملة من الحاجات الرئيسة والثانوية، ممّا لا حاجة إلى عرضها، بقدر ما تمسّ الحاجة إلى تحديد ( الدعاء ) بها، من حيث معطياته النفسية ومساهمته في التفريج عن شدائد الحياة، حتى إن المُلاحِظ يمكنه أن يستقرئ غالبية الحاجات الفردية ليجد أن لكلٍّ منها ( وثيقة ) من الدعاء تتكفّل بمعالجة ذلك.
وأهميّة ( الدعاء ) المذكور تتمثّل في كونه - أي الدعاء - يعدّ طريقة للتفريج عنها من جانب، أو تعويضها - لا أقلّ - بالإشباع العقلي من جانب آخر، وهو أمرٌ عالجناه مفصلاً في دراساتنا النفسية عن ( الدعاء ) فيما لا حاجة إلى إقحامه في دراستنا الأدبية.
٣ - السمات الفنية:
لحظنا في نماذج من نصوص الدعاء، أكثر من سمة فنيّة تتصل بأدوات التعبير، مثل ( الإيقاع ) و( البناء الهندسي )، ويمكن القول بأن ( الدعاء ) يظل أكثر الأشكال التشريعية احتشاداً بأدوات الفنّ، بخاصة عنصر ( الإيقاع ). ولعلَّ السرّ الفنّي وراء ذلك، كامنٌ في طبيعة عنصر ( التلاوة ) التي يمتاز بها الدعاء عن غيره. فالدعاء ( يُتلى )، لا أنه ( يُسمَع ) أو ( يُقرأ ) فحسب، وتبعاً لذلك ؛ فإن ( التلاوة ) تتطلب إيقاعاً يتناسب مع وحداته الصوتية التي تنتظم في ( سجع ) أو ( تجانسٍ )، لا انَّه خاضعٌ لإيقاع داخليّ فحسب.
وأما عنصر ( البناء )، فيمكننا أن نُدرك أهميته أيضاً من خلال الطابع النفسي الذي ينتظم الأدعية، لبداهة أن الأدعية إنما تصاغ من أجل الإفصاح عن حاجات الشخصية بطريقة خاصة، هي ( الانفعالُ ) بها. وحينئذ لابدَّ أن تُصاغ وفقاً للعمليات النفسية التي يستثيرها ( منبّه ) محدّد، و( تستجيب ) له بنمط خاص، ممّا يعني أنَّها - أي الأدعية - تخضع لبناء هندسي، يأخذ العمليات النفسية المذكورة بنظر الاعتبار. ولنأخذ هذا الدعاء مثلاً:
١ - ( إلهي إليكَ أشكو نفساً بالسوء أمَّارة، وإلى الخطيئة مبادرة، وبمعاصيك مولعة، ولسخطك متعرّضة. تسلك بي مسالك المهالك، وتجعلني عندك أهون هالك. كثيرة العلل، طويلة الأمل: إن مسَّها الشرّ تجزع، وإن مسَّها الخير تمنع. ميَّالةً إلى اللعب واللهو، مملوءةٌ بالغفلة والسهو. تسرع بي إلى الحوبة وتسوّفني بالتوبة ).
٢ - ( إِلهي: أشكو إِليك عدواً يضلّني وشيطاناً يغويني. قد ملأ بالوسواس صدري، وأحاطت هواجسه بقلبي. يعاضد لي الهوى، ويزيّن لي حبّ الدنيا، ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى ).
٣ - ( إلهي: إليك أشكو قلباً قاسياً، مع الوسواس متقلّباً، وبالرين والطبع متلبِّساً، وعيناً عن البكاء من خوفك جامدة، وإلى ما يسرّها طامحة ).
٤ - ( إلهي: لا حول ولا قوة إلاّ بقدرتك، ولا نجاة لي من مكاره الدنيا إلاّ بعصمتك، فأسألك... ).
فهذا النصّ يتضمّن أربعة مقاطع، كل مقطع منها موصول بما قبله وبما بعده. فالمقطع يتحدث عن نفس أمَّارة بالسوء، بالعصية، بالخطيئة... نفس هذا المقطع يعرِّض جانباً من المفردات التي أشار إليها، مثل: كثرة العلل والأمل والجزع واللعب والمنع...، أي: صِيغَ بنحوٍ يتلاحم عضوياً بالنسبة إلى النفس التي ألمح إلى كونها أمَّارة بالسوء، ثم تفصيل الإجمال المذكور بمفردات من السلوك المنتسب إلى ذلك.
٢ - أما المقطع (٢)، فقد تحدّث عن ( المنبّه ) للسلوك المذكور، متمثِّلاً في: ( الشيطان )... ثم عرض مفردات ( التنبيه ) متمثّلة في: الوسوسة، تزيين الدنيا... إلخ، حيث فصّل إجمال المنبّه المذكور.
٣ - المقطع (٣) يترتّب على سابقه، وهو: الطبع والرَّين على الفؤاد، نتيجةً لممارسة المفردات التي عُرِضت في المقطع.
٤ - المقطع (٤): يتجه إلى ( الله ) لإنقاذ النفس من السوء الذي فصّلت الحديثَ عنه
المقاطعُ الثلاثة التي أشرنا إليها.
إذن: ( التنامي العضوي ) من الوضوح بمكان ملحوظ في النصّ المتقدم.
* * *
أما عنصر ( الصورة )، فإن استخدامه يضمر حجماً بالقياس إلى ( الإيقاع ) و( البناء )، بخاصة الصورة غير المباشرة. بَيْد أن ذلك لا يعني ضمورها في الحالات جميعاً، بقدر ما يتطلّب الموقف النفسي ذلك.
إن بعض المواقف تستلزم دلالاتُها إلحاحاً في أغوار النفس وتشابك حالاتها، حيث لا يتاح ( للإيقاع ) الخارجي وحده أن يبرز تشابك الحالات الوجدانية، بقدر ما يُتاح لعنصر ( الصورة ) تحقيق ذلك، بما تنطوي عليه طبيعةُ ( الصورة ) من إيحاءات ورموز وكشوف، تبلور التشابك المذكور.
وإليك المقطع رقم ( ٢ ) من دعاء ( العارفين ) في الصحيفة السجَّاديَّة:
( إلهي: فاجعلنا من الذين ترسَّخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم، وأخذت لوعة محبّتك بمجامع قلوبهم. فهم إلى أوكار الأفكار يأوون، وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون، ومن حياض المحبّة بكأس الملاطفة يكرعون، وشرائع المصافاة يردون... ).
هذا المقطع مجموعة من ( الصور ) الفنية، تتوالى واحدةً بعد الأخرى دون أن يتخلّلها تعبيرٌ مباشر. فالقيم الوجدانية في هذا المقطع تتناول أغوار العلاقة بين الله والعبد: من حيث ( عمق المعرفة ) التي لا تتأتّى عند العامة من الآدميين، ومن حيث ( عمق الوجد ) الذي لا يُتاح بسهولة لدى الغالبية منهم، وهو أمرٌ يتطلّب الركون إلى ( تعبير مصوَّر ) يُشحن بدلالاتٍ ثانوية وإيحاءات شتّى، تتوافق مع تشابك وتجذّر ( المعرفة ) و( الوجد ).
لذلك اتَّجه النص إلى رصد علاقات جديدة بين الظواهر وفق تركيبة خاصة، منها: التركيبة الاستعارية، المتمثّلة في رصد العلاقة بين ( أشجار الحدائق ) و( أشواق الصدر )، من حيث ترسُّخها وتغلغلها وتعمّقها داخل النفس، فالشجر بقدر ما تمتدّ جذوره إلى باطن الأرض يأخذ ثباتاً أشد، يقابله الشوق الذي تُرسَّخ إمكاناته بقدر ما يتكاثر ويتنامى.
فهنا لو التجأ النصّ إلى التعبير المباشر، لَمَا زاد على ذلك بقولنا مثلاً: ( اللهم: اجعل أشواقنا شديدةً نحوك )، لكنّه بارتكانه إلى عنصر ( الصورة )، حقّق ظاهرة تغلغل الشوق وشدّته وتناميه: حيث نقل القارئ إلى تجربة الشجر والمزرعة ليوحي إليه كثافة الشوق. وكان من الممكن أن يكتفي
النصّ بمجرد ( الشجر ) دون أن يضيف إليه ( الحدائق )، مادام النموّ يتحقق في أية أرض صالحة للزراعة، ولكن بما أن النص لم يستهدف مجرّد تغلغل الشوق في الأعماق ليكتفي بالزرع، وإنما استهدف - أيضاً - الإشارة إلى المتعة الجمالية التي نشاهدها في ( حديقة ) تنتظم أشجارها وتتناسق، فتجمع إلى عملية ( النبت ): ( التنظيم الجمالي ) أيضاً. حينئذٍ فإن النصّ يكون قد استهدف لفت النظر إلى مدى الفرح والحبور اللذَيْن تنثرهما محبّةُ الله في صدور ( العارفين )، فيما يتحسّسونهما ببالغ الجمال الذي يتلاشى معه أيُّ متاعٍ دنيويٍّ عابر.
ولو ذهبنا نتابع سائر ( صور ) المقطع، للحظنا أمثلة هذه الظاهرة التي انطوت الصورةُ المتقدمةُ عليها، فيما لا حاجة إلى الوقوف عندها.
المهم: أردنا أن نلفت الانتباه على الأسرار الفنية الكامنة وراء حشد بعض الأدعية بعنصر ( الصورة )، وضمور ذلك في سائر الأدعية. كما أردنا لفت الانتباه على الأسرار الفنية الكامنة وراء حشد غالبية الأدعية - على الضد في عنصر الصورة - بعنصر ( الإيقاع )، وصلة ذلك بعنصر ( التلاوة ) الذي يميّز ( الدعاء ) عن غيره من فنون التشريع الإسلامي، بالنحو الذي فصَّلنا الحديث عنه.
الزيارة
الزيارة: شكلٌ فنيّ يتمثّل في صياغة العواطف البشرية حيال أهل البيتعليهمالسلام . وإذا كان ( الدعاء ) يتمثَّل في التوجه بالعواطف إلى الله تعالى، فإن ( الزيارة ) تتمثّل في التوجه بالعواطف إلى أهل البيتعليهمالسلام ، من خلال كونهم ( شفعاء ) أو ( وسائل ) بين الفرد والله.
وأهمية هذه العواطف لا تتجسّد في مجرد ( الشفاعة )، بل في التعبير الموضوعي عن محبّة الزائر لأهل البيتعليهمالسلام ؛ بصفتهم النموذج الأرفع للوظيفة الخلافية، حيث اصطفاهم الله - دون خلقه - لممارسة الوظيفة المذكورة في أرفع صُعُدِها.
مضافاً إلى ذلك، فإن ( الزيارة ) تعدّ نمطاً من ( الوفاء ) لشخصيات أهل البيتعليهمالسلام . فالميت العاديّ من البشر طالما يتّجه ذووه وأصدقاؤه وجيرانه ومقدِّروه بشكل عام، إلى تجديد ذكرياتهم مع الفقيد في شتّى المناسبات، بحيث تعدّ قراءة الفاتحة ونحوها تعبيراً عن ( الوفاء ) حيال الفقيد.
أما أهل البيتعليهمالسلام بصفتهم النموذج العبادي الذي أشرنا إليه، فإن ( الزيارة ) لهم من خلال المشاهد المقدسة، أو مطلق ( الزيارة )، تعدّ تعبيراً خاصاً له تميّزه وتحدّده عن سائر الناس، بحيث تتناسب ( الزيارة ) - بما تنطوي عليه من دلالات سنشير إِليها - مع الموقع الخلافي الذي يحتلّه أهل البيتعليهمالسلام .
وتتمثّل ( موضوعات ) الزيارة في جملةٍ من الدلالات: تبدأ - عادةً - بالثناء على الله، ثم ( السلام ) على ( المزور )، ثم التقويم لشخصيّته العبادية، ثم العرض لبعض الشدائد التي واجهها ( المزور)، بخاصة أن كلاًّ من شخصياتهم (ع) بين مقتول أو مسمومٍ، ثم اختتام ذلك بالدعاء لنفسه.
نموذج رقم (١):
من زيارة للنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم :
( أشهد أن لا إِله إِلاّ الله.. وأشهد أنك رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم .. وأشهد أنك قد بلّغت رسالات ربّك، ونصحت لأُمتّك، وجاهدتَ في سبيل الله.
اللَّهُم أعطه الدرجة الرفيعة، والوسيلة من الجنة.
اللَّهُم إنك قلت:( وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً ) ، وإنّي أتيت نبيّك تائباً من ذنوبي.. ).
فالملاحظ في هذا النص أنَّه - كما أشرنا - بدأ بالثناء على الله، ثم ( المزور )، ثمّ التقويم لشخصيته، ثم الدعاء له، ثم الدعاء لنفسه.
وأهمية هذا النمط من ( الزيارة ) أنها تُدرّب الشخصية على السلوك السويّ ؛ من حيث شدّها إلى التفكير بوظيفتها العبادية حيال الله وأصفياء عباده، ومن حيث تذكيرها بالمبادئ التي ينبغي أن تلتزم الشخصية الإسلامية بها خلال ( تقويمها ) لشخصية ( المزور )، المتمثِّل في جهاده في سبيل الله وتأدية وظيفته (ع). فضلاً عن أنها تستثمر ذلك للتنبيه على سلوك (الزائر) واستحضاره لذنوبه، ممّا يحمله على تعديل السلوك. فضلاً عن أن ( الوفاء ) نفسه - من خلال ممارسة الزيارة - يُعد مواصلة للتدريب على السلوك السويّ.
هذا كلّه من حيث الدلالات الفكرية والنفسية لممارسة ( الزيارة ). أما من حيث القيم الفنية ل- ( الزيارة ) بصفتها شكلاً أدبيّاً له خصائصه الجمالية: من صورةٍ وإيقاع وبناءٍ، فإن هذا الشكل لا يختلف عن سائر الأجناس الأدبية التي وقفنا عليها في نصوص الفنّ التشريعي، من حيث كونه يرتكن إلى أدوات جمالية يخرجها من نطاق التعبير العادي إلى صعيد التعبير الفنّي، وهو ما سوّغ لنا أدراجه ضمن دراستنا للأدب التشريعي.
ويمكننا ملاحظة البُعد الفنّي لنصوص ( الزيارة ) في نماذج منها:
نموذج رقم (٢):
من زيارة لعليّ (ع):
( السلام عليك يا أمين الله.. أشهد أنّك جاهدت في الله حقّ جهاده.. حتى دعاك الله إلى جواره ،
وقبضك إِليه باختياره.
اللَّهُم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، مُحبَّة لصفوة أوليائك... ).
فالملاحَظ هنا أن النصّ ارتكن إلى ( الإيقاع ) في قراري ( الراء ) و( الهمزة )، كما أن ( توازن ) الجُمل ساهم في تجلية الإيقاع المذكور ؛ ممّا يجعل النصّ ليس مجرد تعبير عادي، بل يجسّد تعبيراً له جماليته التي ابتعثها ( الإيقاع ) على النحو المذكور.
وهذا فيما يتصل بعنصر ( الإيقاع ).
أما فيما يتصل بعنصر ( الصورة )، فيمكننا ملاحظته في:
نموذج رقم (٣):
من زيارة للحسين (ع):
( أشهد أنك كنت نوراً في الأصلاب الشامخة، والأرحام المطهّرة. لم تنجّسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمّات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين، وأركان المؤمنين... ).
هذا المقطع من ( الزيارة ) يتضمّن - كما هو بيّنٌ - حشداً متتابعاً من ( الصور )، أي التعبير غير المباشر، بحيث لم يتخلّلها نثرٌ غير صُوَري.. ومنها: صورتا ( لم تنجّسك الجاهلية بأنجاسها )، و( لم تلبسك من مدلهمَّات ثيابها )، فهذه الأخيرة - على سبيل المثال - تعتمد أطرافها على ( خبرة مألوفة )، هي: المدلهمّة من الثياب، أي المكثّفة أو شديدة السواد، حيث لم يكتف النص بخلع سمة ( السواد ) على الثياب تعبيراً رمزياً عن مجرد وساخة السلوك الجاهلي، بل تجاوزه إلى ( السواد المكثّف )، أي شديد السواد، معبّراً بذلك عن أشد أشكال الوساخة الجاهلية.
فالنص استطاع بهذا النمط من التركيب الصوري أن يستثير القارئ وينقله إلى تجارب الفكر الجاهلي في أشد أشكالها مفارقةً، مبيّناً أن الإمام الحسين (ع) وُلِدَ نقيّاً لم تعْلَق به أيَّة وراثة طارئة من بيئة الجاهليّة، التي تسلّلت، أو احتفظت بعناصرها، في أصلاب كثيرٍ من الأشخاص الذي تمرّدوا على قيم الإسلام وأطلقوا لشهواتهم العنان في ممارسة السلوك العدواني.
مضافاً إلى ذلك فإن البناء الهندسي لهذا المقطع من ( الصور ) المتلاحقة، التي بدأت بالحديث عن ( الأصلاب الشامخة )، و( الأرحام
المطهَّرة )، ثم وصلها بما لم ( ينجّس ) بما هو جاهلي، ولم ( يُلبس بما هو مدلهمّ ) منها، ثم وصلها - بعد ذلك - بصورتي ( الدعائم ) و( الأركان)...
أقول: إن هذا الحشد من ( الصور الفنية )، قد صيغ وفق بناء هندسي مُتلاحمٍ متآزرٍ متواشجٍ، ينتقل بنموٍّ وتطويرٍ فنيّين: مِن الأرحام، إلى الثياب، مروراً بعدم التلوّث بالمفارقات، بحيث تُستكمل - من خلالها - ( صورة ) استمرارية، متواصلة الأجزاء بعضها بالآخر، تماماً كما هو الحال في بناء العمارة التي تتناسب طوابقها بعضاً مع الآخر.
المهم، أن كلاًّ من عنصر ( الصورة ) و( البناء الهندسي )، لها في هذا النص - فضلاً عمّا لحظناه من عنصر ( الإيقاع ) في النصّ الأسبق - ما يدلّنا على أن ( الزيارة )، بصفتها نمطاً واحداً من أشكال التعبير، تظلّ مثل سائر الأجناس الأدبية المأثورة عن ( التشريع)، شكلاً تعبيريّاً له خصائصه الفنِّية على اختلاف عناصرها.
الحديث الفنّي
نقصد ب- ( الحديث الفني ): الأحاديث التي تعتمد عنصر ( الصورة ) بخاصة شكلاً لها - علماً بأنَّ عنصر ( الإيقاع ) ينتظم بدوره كثيراً من الأحاديث - بالقياس إلى غالبيّة الأحاديث التي تعتمد التعبير المباشر شكلاً خارجيّاً لها.
و( الحديث ) هو: مجرد تقريرٍ أو توصيةٍ فقهيّة أو أخلاقية أو فكريّة، يُتناوَل من خلال كلماتٍ محدودة، إِلاّ أن الكثير منه يتّجه إلى التعبير غير المباشر عن المضمونات التي يستهدف المشرّع توصيلها إلى القارئ.
ويُلاحظ أن ( العنصر الصوري ) الذي ينتظم قسماً من الأحاديث التي نتناولها بالدراسة، يجد مستوياته الثلاثة من التركيب الفنّي، ونعني بها: ( الصورة البسيطة )، ( الصورة المركّبة )، ( الصورة الاستمرارية ).
ولنتقدم ببعض النماذج، ونبدأ ب-:
الصورة الاستمرارية:
قال (ع):
( إنما المرء في الدنيا غرضٌ تنتضل فيه المنايا، ونهبٌ تبادره المصائب.. ومع كلّ جرعة شَرْق، وفي كلّ أكلة غُصَص.. ولا ينال العبدُ نعمةً إِلاّ بفراق أخرى، ولا يستقبل يوماً من عمره إلاَّ بفراق آخر من أجَلِه. فنحن أعوان المنون، وأنفسنا نصب الحتوف. فمن أين نرجو البقاء وهذا الليل والنهار لم يرفعا من شيءٍ إلاّ أسرعا الكرة في هدم ما بنيا، وتفريق ما جمعا ؟! ).
إن هذه ( الصورة الاستمرارية ) حافلة بأشدّ الأطراف إثارة من حيث تفريعها وتشابكها. إنها تريد أن تقول لنا بأنّ كلاًّ من ( الموت ) و( شدائد الحياة ) هما نصيب الدنيا، وإلى أننا - بذواتنا نحن - نساعد الموتَ على تحقيق هدفه حيالنا، لكن كيف ذلك ؟
هذا ما تضطلع به ( الصورة الاستمرارية ) التي تثري تجاربنا وتدفع بنا إلى استجابة فاعلة في عملية ( التعديل ) للسلوك. ويعنينا منها معالجة أطراف الصورة، ممّا نبدأ بتفكيكها أوّلاً:
المرء في هذه الدنيا مثل ( الهدف ) الذي تتّجه المنايا إلى إصابته.. هذا من حيث الموت.
وحتى من حيث ( الحياة ) ذاتها، فإن المرء فيها فريسة للشدائد، فما أن يَتناول جرعةً من الماء حتى يغصّ بها فمه، وما تناول طعاماً إلاّ غصّ به ( الماء والطعام هنا ( رمزان ) للذائد الحياة، بصفة أن التغذية منحصرة بهما ) ممّا يعني أن النصّ يريد أن يقول لنا: ( إن اللذائذ مشفوعة بالشدائد ).
والآن: إذا كانت الحياة مرشَّحة للانطفاء، واللذائذ مشفوعة بالشدائد، حينئذٍ: كيف يتحرّك الإنسان حيالهما ؟ انطفاء كلٍّ من الحياة واللذائذ يسير جنباً إلى جنب مع استمراريتهما أيضاً ؛ إذ لا يتاح للإنسان أن يظفر بنعمة إلاّ ويفارق أُخرى، ولا يستقبل يوماً من عمره إِلاّ بفراق آخر من أجَلِه.
ولنقف مليّاً عند هذه ( المعادلة ) المدهشة التي يتغافلها الإنسان إننا بقدر ما نفرح بمرور يومٍ جديدٍ علينا، ينبغي أن نحزن على اليوم السابق عليه أيضاً، لأنَّ مضيّ ( السابق ) مؤشرٌ إلى ( نقصٍ ) من العمر. إِذن: نحن أعوان ( الموت ) عِبْر فرحنا باستقبال اليوم الجديد. وإذن - أيضاً - فيم التفكير باستمرارية الحياة !!
إن أدنى تأمل لهذه الصورة الاستمرارية، كافٍ بأن يغيّر استجابة الإنسان، وينقله من ظاهرة تغافله عن ( الحياة ) إلى الوعي الحادّ بها.
والمهم، أن الصورة الفنيّة - على النحو الذي حلّلناه - ساهمت من خلال الاستعارات والرموز المختلفة، بتعميق الدلالة المتنوعة التي استهدفها الحديث في هذا الصدد، وهو أمرٌ لم يتح للتعبير - إذا كان مباشراً - أن يتوفّر عليه بهذا النحو من الإثارة التي لحظناها في الصورة الفنيّة التي قدّمها (ع).
الصورة المركّبة:
قال (ع):
( مثل الدنيا مثل ماء البحر: كلَّما شرب منه العطشان ازداد عطشاً حتى يقتله ).
إن هذه الصورة المركَّبة من عمليتين: ( الدنيا وماء البحر )، و( الشرب والقتل )، تجسّد
بوضوح هدفَ مثل هذه الأداة الفنيّة بدلاً من التعبير المباشر.
فبدلاً من أن تقول التوصية: إن الدنيا تجرُّ صاحبها إلى ( الإحباط ) بدلاً من ( الإشباع ).. أقول: بدلاً من أن يتمّ تقرير هذه الحقيقة بلغة عادية، لا تحمل القارئ على مزيدٍ من الاستثارة والتأمّل، تتجه إلى عنصر ( الصورة ) بغية حمل القارئ على التنبّه لدقائق السلوك وتفصيلاته، التي تفضي - من خلال الطموح الدنيوي - إلى حرمان الشخصية في نهاية المطاف من تحقيق إشباعه. فإذا كان ( الهدف ) من وراء اللهاث نحو الحياة هو ( الإشباع)، حينئذٍ فإن ( عدم الإشباع ) هو الذي سيتوِّج سلوك الشخصية، أي على العكس تماماً من هدفها.
وهذه الحقيقة لا يتاح لها أن تتبلور بهذا النحو من الوضوح إلاّ من خلال ( صورة )، أو تقديم ( مَثَل )، أو ( تشبيه ) بين الطموح الدنيوي وبين نتائجه، فكان ( المثل ) هو:
أولاً: تقديم ظاهرة حسّية مألوفة في حقل التجربة اليومية، وهي: ( ماء البحر ).
ثم: تقديم ممارسة مألوفة أيضاً، هي: الشرب.
ثم: استخلاص ظاهرة جديدة لم تذكرها الصورة، وهي: ملوحة الماء.
ثم: استخلاص الظاهرة المطلوبة من الصورة بشكل عام، وهي: ازدياد العطش.
ثم: استكمال الظاهرة المذكورة، وهي: القتل.
إِذن: نحن أمام خمسة عناصر من ( الأطراف ) التي تنتظم الصورة المتقدِّمة: حيث اختُزِل البعضُ منها ( الملوحة ) واستُخلِص منها أكثر من نتيجة ( ازدياد العطش، القتل )، فضلاً عن الاستخلاص العام الذي أدركه القارئ بوضوح: حينما عرف بأنّ اللهاث وراء الحياة الدنيا يؤدِّي إلى حرمان الشخصية من الإمتاع الذي تنشده.
* * *
ويمكننا ملاحظة الكثير من نصوص الحديث التي تتضمّن ( الصورة المركبة )، فيما تتميز عن ( الصورة الاستمرارية ) و(الصورة المفردة ) بأنها تتناول ظاهرة سريعة، وليس ( موقفاً ) يتطلّب بعض التفصيل الذي نلحظه في الصورة الاستمرارية.
كما أنها تتميز عن ( الصورة المفردة ) - التي سنتحدّث عنها - بكون هذه الأخيرة مجرد تركيبٍ لظاهرة مفردة، تتَّسم بالبساطة ولا تتطلّب أدنى تفصيل. بينا نجد ( الصورة المركبة ) تقف وسطاً بين نمطي الصورتين الاستمرارية والمفردة، بحيث تأخذ قسطاً من التفصيل، لا التفصيل الكامل، كما لا تكتفي بمجرد التركيب العابر.
ولعل غالبية ( الأمثال ) التي نلحظها في ( الحديث )، أي الصور التي تعتمد أداة الشبه (مثل)، تظلّ منتسبةً إلى الصورة المركّبة.
وإليك نماذج من ( الأمثال ) التي صاغها النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم في هذا الصدد.
( مَثل أهل بيتي مثل سفينة نوحٍ: مَن ركب فيها نجى، ومَن تخلّف عنها غرق )، ( مثل القلب مثل ريشةٍ بأرضٍ تقلّبها الرياح )، ( مثل المؤمن كمثل العطَّار: إنْ جالسته نفعك، وإنْ ماشيته نفعك، وإنْ شاركته نفعك ).
فالمُلاحظ في ( الأمثال ) المتقدّمة أن ( التفصيل ) يأخذ مساحة محددة، هي: الركوب والنجاة، والتخلّف والغرق ( في الصورة الأولى)، والريشة وقد قلّبتها الرياح ( في الصورة الثانية)، ونفع ( العطر ) في المجالسة والمشي والمشاركة.
ومن الممكن أن تتضمّن ( الأمثال ) صوراً استمرارية متداخلة كما ورد عن النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم أيضاً، إلاّ أن ذلك نادرٌ بالقياس إلى ( المثل ) الذي يتناول عادةً صورة مركبة من طرفين متداخلين على النحو الذي لحظناه.
الصورة المفردة:
وهذا النمط من التركيب يشكّل الصورة المعروفة، التي طالما نواجهها في غالبية ( الأحاديث ) التي تتناول ظاهرة سريعة تتصل بسلوكٍ مفرد، أي بسمة أخلاقية أو عبادية بشكل عام، حيث لا يتطلّب الموقف أكثر من ( تقريب ) السمة أو السلوك بصورة حيّة، تعمّق من دلالتها لدى القارئ.
وإليك بعض النماذج:
قال الإمام عليّ: ( القناعة مالٌ لا ينفد ).
وقال الإمام العسكري: ( الغضب مفتاح كلّ شر ).
وقال الإمام الهادي: ( الدنيا سوق رَبَحَ فيها قوم وخَسِرَ آخرون ).
فالملاحظ في هذه ( الصور ) أنها تتناول ( تركيباً مفرداً )، هو: المال الذي لا ينفد، والمفتاح للشرّ، والربح أو الخسار في السوق. وقد ساهمت هذه الصور بتعميق الدلالة التي يستهدفها الأئمة ( ع ). فالقناعة، وهي سمة نفسية يتطلّب توضيحها شرحاً مفصّلاً يضطلع به عالم النفس أو عالم الأخلاق ؛ ليدلّل من خلال ذلك على أهمية القناعة وانعكاساتها على سلوك الشخصية من حيث تطلّعاتها إلى إشباع الحاجات، بينا اكتفى الإمام عليّ (ع)
بتركيب ( صورة )، هي: المال الذي لا ينفد. فترك القارئ يستخلص بنفسه أهمية القناعة بمجرد استحضاره لظاهرة المال الذي لا ينفد، حيث يتوفّر لديه بأن المال الذي لا حدود له يحقق أعلى مستويات الإشباع، وهذا يعني أن القناعة تحقّق المستويات المذكورة من الإشباع.
وإِذن، بهذا النمط من التركيب الصوري، أمكن للإمام (ع) أن يحدِّد مفهوم القناعة، دون الركون إلى الملاحظات والتحليلات النفسية التي يتطلّبها مثل هذا المفهوم.
والأمر ذاته حينما نتّجه إلى الصورتين اللتين قدّمهما الإمامان الهادي (ع) والعسكري (ع) في ملاحظتهما للدنيا وللغضب. فالدنيا وطريقة التعامل معها تتطلّب شرحاً مفصّلاً بدوره، إِلاّ أن الإمام الهادي (ع) اختزل كل ذلك من خلال صورة ( السوق ) التي تدرّ الربح أو الخسار، بقدر ما يستخدمه التاجر من ذكاءٍ اجتماعي في تصرفاته. و( الغضب ) - وهو سمة نفسية ذات انعكاسات متنوعة على السلوك - طالما تصاحبه انفعالات جسمية يعرض علماء النفس لآثارها تفصيلاً، كما يعرضون لانعكاساتها النفسية: من توتّر وصراع وما إليهما، فيما اختزل الإمام العسكري (ع) كلّ ذلك، وأوضحه من خلال صورة ( المفتاح ) الذي يجعل أبواب الشّرّ بكلّ مستوياتها مفتوحة حيال الغاضب، بحيث يستخلص القارئ كلّ الشرور الجسمية والنفسية التي يمكن أن تترتّب على ظاهرة ( الغضب ).
الفهرس
الإسلام والفن الدكتور محمود البستاني ١
الإسلامُ والفَن ٣
( كلمةُ المَجمع ) المقدمة: ٥
ما هو الفنّ ؟ ٧
الفنّ والالتزام ٩
الفنّ وعناصره: العنصر التخيُّلي ١٥
التخيّلُ والصورة ١٨
العنصرُ العاطفي ٢٢
العنصرُ الإيقاعي ٢٦
العنصرُ البنائي ٢٩
الفنّ وأشكاله الشِّعر: ٣١
الشِعرُ والأُغنية ٣٥
الشِعرُ والتجربة الجنسية ٣٩
القصّة والمسرحية ٤٢
الشخصية في العمل القصصي: ٤٧
الخطبة، الخاطرة، المقالة ٥٠
النحت والرسم ٥١
الفنّ واتجاهاته: الاتجاه التقليدي: ٥٤
الاتجاه الرومانسي ٥٥
الاتجاه الرمزي الاتجاه السريالي ٥٦
اتجاهات فكرية ٥٧
الفنّ ودراسته نظرية الفنّ: ٥٩
النقد الأدبي أو الفنّي ٦١
لغة النقد ٦٣
النقد واتجاهاته الاتجاه العقائدي: ٦٦
الاتجاه الجمالي: ٦٩
الاتجاه الاجتماعي: ٧١
الاتجاه النفسي: ٧٥
البلاغة والنقد ٨٠
تاريخ الأدب والفنّ ٨٤
الأدب التشريعي ٩٠
النصّ القرآني ٩٢
بناء القصة القرآنية قصة طالوت: ١٠٢
المباغتة والمماطلة والتشويق: ١٠٦
الزمان النفسي: ١١٠
الأبطال في القصة: ١١٥
عنصر الحوار في القصة: ١٢٢
[ أنماط الصور القرآنية: ] ١٣٦
العنصر الإيقاعي: ١٤٣
[ أدب السُّنَّة ] الخطبة: ١٤٥
( الكتاب... ) ١٥٢
( المقال... ): ١٦٢
الخاطرة...: ١٦٥
الدعاء ١ - السمات العامة: ١٧٠
٢ - السمة الموضوعية والفردية: ١٧٤
٣ - السمات الفنية: ١٧٥
الزيارة ١٧٩
الحديث الفنّي الصورة الاستمرارية: ١٨٣
الصورة المركّبة: ١٨٤
الصورة المفردة: ١٨٦
الفهرس ١٨٩