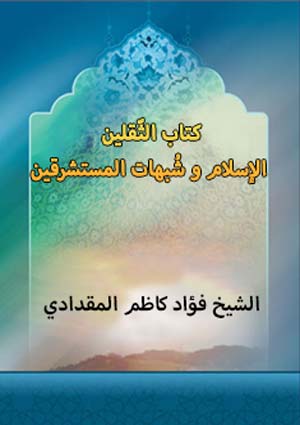كتاب الثّقلين
الإسلام و شُبهات المستشرقين
الشيخ فؤاد كاظم المقدادي
كتاب الثّقلين
الإسلام و شُبهات المستشرقين
الشيخ فؤاد كاظم المقدادي
المجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام)
سلسلة كُتب دوريّة تصدر عن مجلّة رسالة الثقلين
كَلِمَةُ المَجَلَّةِ
ابتُلي الحقّ على امتداد مسيرة البشريّة بالجهل، ولأنّ مِن طبيعة الإنسان أنْ يكون عدوّاً لما جهل، فإنّ الحقّ بدوره عانى من جهل الجاهلين ومواقفهم المتزمّتة الشيء الكثير، ولكنّ الحقّ هو المنتصر على طول الخطّ؛ لأنّ الله هو الغالب، وليس نصيب الجهل والتزمّت إلاّ الاندحار والخذلان.
والإسلام العظيم رسالةُ خاتم الأنبياء محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إلى الأرض، وهو الحقّ الذي ليس وراءه حقّ، وكيف لا يكون كذلك وهو هديّة الحقّ المتعال إلى عباده؟ إنّه وحي السماء الذي رسمه القرآن الكريم بكلماتٍ من نور، ليكون هدىً لا ريب فيه للعالمين، ومنقذاً لهم من الضلال والظلمات إلى الصراط الجليّ المستقيم.
لقد عانت الأديان الإلهيّة جمعاء، منذ بزوغ شمسها على هذه الأرض ومنذ أنْ صدع الرسُل والأنبياء بها، عانت العداء السافر، والمواجهات الساخنة التي كان الجَهَلة يواجهون بها رُسُل الله تعالى وأنبياءه ورسالاتهم الحقّة، إذ لم يقف هؤلاء عند حدّ رفضهم لما يُحييهم، بل تجاوز الأمر ذلك إلى الحرب الشرسة بالكلمةِ واليد، ولم يسلم نبيّ قطّ من مثل هذه المواقف، ولم تنجُ رسالة من مثل هذا العداء.
وكان الإسلام المحمّديّ الأصيل هدفاً لسهام الأعداء وغرضاً لنهجهم العدائي، لا لشيءٍ إلاّ لأنّ الإسلام هو الخطر الحقيقي الذي يهدد أفكارهم ومناهجهم، ويقف حائلاً منيعاً دون تحقّق رَغَبَاتهم الشرّيرة وأطماعهم الخبيثة في
نشر الانحراف والزيغ، وتمكين الطواغيت مِن التحكّم والسيطرة اللاشرعيّة على خيرات البلاد ومقدّرات العباد.
وكانت الأساليب التي يستخدمها أعداء الإسلام متعدّدة ووسائلهم مختلفة، وكلّها تصبّ - رغم اختلافهم فيما بينهم - في هدفٍ واحد هو القضاء على الإسلام ورسالته الخالدة، فكانت الحرب النفسيّة والاقتصاديّة والفكريّة والثقافيّة والعسكريّة في نهاية المطاف، عندما تكون الظروف مواتية للأعداء لشنّ حربهم على الإسلام والمسلمين، كما هو الحال في الحروب الصليبيّة الممتدّة منذ مئات السنين، والتي لم يخمد أوارها ولم تهدأ فورتها منذ اشتعالها.
وقد كانت تلك الحروب على ثلاثة خطوط:
١ - الخطّ العسكري في المواجهة، متمثّلاً بالهجوم على البلاد الإسلاميّة واحتلال أراضيها وقتل أبنائها وتشريد رجالها، وغيرها من الأساليب ووسائل المواجهة العسكريّة.
٢ - الخطّ الاقتصادي، متمثّلاً بنهب خيرات البلدان الإسلاميّة وفرض الحصار عليها.
٣ - الخطّ الثقافي الفكري، متمثّلاً بالغزو الثقافي المقيت وما يمهّد له من خطط جهنميّة، هي تشويه المفاهيم الإسلاميّة والدسّ والتشكيك في مصداقيّتها ونهجها القويم.
وهذا الخطّ هو الذي عمِل عليه أكثر المستشرقين، وعبّأوا كلّ طاقاتهم وسخّروا كلّ إمكانيّاتهم من أجل إحكام خططه وتنفيذ فقراته، إذ إنّ هدف هؤلاء المستشرقين هو المسلم الأصيل، وقبله المسلم العادي، فإنّ بذر الشكّ في نفسه وزعزعة إيمانه بالمبادئ الحقّة التي يعتنقها، هو خير سبيل لحرفه وإبعاده عن دينه ثم السيطرة عليه نهائيّاً وتحويله من عدوٍّ للكفر والفساد إلى عدوٍّ للإسلام والرشاد.
إنّ هؤلاء المستشرقين ببحوثهم ودراساتهم الاستشراقيّة حول الإسلام والمسلمين مهّدوا الطريق لزرع بذور الشكّ من خلال دسّهم وتشويههم للمبادئ الإسلاميّة، وحقّقوا في نفوس بعض المسلمين قابليّة الاستعمار، فأصبح البعض من المسلمين يدعون إلى الانحراف والتبعيّة للغرب، ويحاربون الإسلام وعقيدته جهلاً منهم وضلالاً.
لقد تقنّع هؤلاء المستشرقون بقناع البحث العلمي لإضفاء الصبغة العلميّة على بحوثهم، حتّى يتمكنّوا مِن خلالها من خداع وتضليل الجَهَلة وضِعَاف النفوس الذين لم يدخل الإيمان قلوبَهم، ولم تكن لهم القدرة على التمييز بين الخطأ والصواب والغثّ والسمين.
والكتاب الذي بين يديّ القارئ الكريم يُسلّط الأضواء على واقع المستشرقين، وطبيعة بحوثهم ودراساتهم وأهدافهم، ومدى تأثيرهم في مسيرة الأحداث، ويفتح أعيُن المسلمين على هذا الموضوع الحسّاس والخطير، حتّى يكون المسلم على بصيرةٍ من أمره واعياً لما يحيكه أعداء الإسلام من مؤامرات، محصّناً بالفكر والحجّة والدليل لردّ جميع الشبهات التي يثيرها هؤلاء المستشرقون ضدّ إسلامه الحنيف وعقيدته الخالدة.
ويمتاز هذا الكتاب بأُسلوبه السلس ومنهجيّته العلميّة التي استندت في مناقشتها وطرحها إلى المصادر الموثوقة، وقد بذل الكاتبسماحة الشيخ المقدادي الجهد الكثير من أجل التعرّف على الأساليب والأهداف والنتائج التي وصل إليها المستشرقون، وناقش الشبهات بروح علميّة موضوعيّة بعيدة عن التعنّت والتعصّب.
وسيدرك القارئ الكريم عند متابعته لبحوث الكتاب هذه الحقيقة ويعرف مدى الجهد الذي بذله الكاتب المحقّق في هذا السبيل من أجل الدفاع عن كيان
الإسلام وحومة المسلمين، وقد حدّد وبيّن بصورة خاصّة الكثير من الشبهات التي أثارها أعداء الإسلام، وخاصّةً المستشرقون منهم وردّها رداً علميّاً منطقيّاً لا يدع مجالاً للتردّد في الاقتناع به وقبوله.
نتمنّى أنْ تكون هذه الدارسة القيّمة محلّ اهتمام المسلمين، لكي يتعرّفوا على الملابسات والظروف العصيبة التي مرّ ويمرّ بها الإسلام خصوصاً في هذه الفترة العصيبة، حيث يجتمع كلّ الأعداء شرقاً وغرباً للفتك بالإسلام والمسلمين ( ...وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ.. ) .
صدق الله العليّ العظيم.
هيئة التحرير
مجلّة رسالة الثقلين
مُقدَّمَةٌ
للعلاّمة الشيخ محمّد عليّ التّسخيرى
الأمين العامّ للمجمع العالميّ لأهل البيت (عليه السلام)
لقد كانت فكرة إصدار سلسلة (كتاب الثقلين) فكرة جيدة... يقف القارئ الكريم فيها على كلّ الفكرة التي جاءت متفرّقةً وفي أعدادٍ متعدّدة، ممّا يعطيه صورةً كاملة عن الموضوع... وما انتشر منها لحدِّ الآن يوضّح الفوائد الجمّة من تحقيق هذه الفكرة.
وموضوع هذا الكتاب من أهمّ المواضيع التي شغلت بال المخلصين والمفكّرين من أبناء هذه الأُمّة لعقود طويلة.. إلا وهو موضوع (المستشرقين)، فرغم وجود بعض العناصر المخلصة أو المحايدة فيهم، فإنّ الغالبيّة العظمى منهم جاءت لتدرس الإسلام مِن خلال موقف نفسي مسبق مِلؤه الحقد والسعي للتشويه - بل والتمهيد - لتحقيق هزيمة نفسيّة للمسلمين تسبق الحملة العسكريّة المنظمة، التي كان يخطّط لها أُولئك الذين دفعوا هؤلاء لمثل هذه الأساليب.
وقد حاول هؤلاء تشويه التاريخ الإسلامي والتشكيك في كلّ المقدّسات الإسلاميّة، وإثارة الشُبهات حول النسب السماوي للقرآن الكريم، والسلوك الطاهر لرسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأهل بيته الطاهرين وصحابته المنتجبين، منتحلين الكثير من القصص ومستغلّين الكثير من الفجوات الموجودة - مع الأسف - في تواريخنا
ومرويّاتنا لتحقيق هدفهم المشؤوم، مما دفع الكاتب الكريمالأُستاذ المقدادي لعرض هذه الشبهات والتنبيه على مكامن الخطر فيها، متتبّعاً نشأة الاستشراق وعوامله ومستعرضاً بعض مدارسه المشهورة ومُركّزاً على ما دسّوه في الإنتاج الموسوعي، ودوائر المعارف الشهيرة، ومبيّناً جوانب الخلْط والخطأ الفادح فيها، فإلى مطالعة هذا الكتاب الجيد ندعو القرّاء الأعزّة راجين للأُستاذ الفاضل الكاتب كلّ موفقيّة وسداد في عمله المبارك.
محمّد عليّ التسخيري
المدخل
أهلُ الكتابِ وَالثَّقلينِ
منذ بزوغ فجر الإسلام، وصدوع الرسول محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بالدعوة الجديدة، تنادت قُوى الكفر والشرك والضلال، وأجمعتَ أمرها على التصدّي لها بكلّ ما تملك من وسائل، وحاولت جاهدةً القضاء عليها في مهدها مستهدفةً ثقليها الكريمين: القرآن المجيد والرسول الكريم (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وأهل بيته الأطهار (عليهم السلام).
وكان لأهل الكتاب، ممّن نكثوا العهد ونقضوا المواثيق المأخوذة عليهم من قِبَلِ أنبيائهم بالالتحام مع الرسالة المحمّديّة، الدور الأكبر والجهد الفاعل في التصدّي والتآمر على شخص الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وعلى الرسالة التي جاء بها.
ولعلّ ما يؤكّد ذلك هو أنّ من أكثر ما تناوله القرآن الكريم ونزلت به آياتٌ كريمة بهذا الصدد يتعلّق بأهل الكتاب، من بيانٍ لطبيعة سلوكهم وموقفهم من الثقلين، وإرشاد الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إلى ما يجب أنْ يتّخذه من موقف رسالي تجاههم.
فقد بلغت الآيات القرآنيّة الكريمة النازلة بهم (٢٦٧ آية تقريباً)، وهذا يدلّ دلالةً واضحةً على أهميّة دورهم، وخطرهم على حركة الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في تثبيت دعائم الرسالة الإسلاميّة، وضمان مستقبلها على صعيد حفظها من التحريف والتزوير، وتبليغها لكافّة الناس، وامتداد لوائها إلى أقصى أمصار الأرض.
ومِن الواضح أنّ الآيات الكريمة في هذا المجال تنقسم إلى قسمين رئيسيّين، وقد يتداخل القسمان في الآية الواحدة وقد ينفصلان، وقد تتداخل مفردتان تفصيليّتان فيها أو أكثر وقد تستقلّ بواحدة.
ونستعرض كلاً منهما كالآتي:
القسم الأوّل
الآيات الناظرة إلى موقف أهل الكتاب من الثقلين، ويُمكن عرضها على شكل عناوين تفصيليّة تُظهر لنا أبرز مواقفهم تلك:
١ - كتمان الحقّ وتحريفه:
وهُم يعلمون... ففي الآيات المبيّنة التالية نرى أنّ كلّ آيةٍ منها تجري مع الخطّ الأساسي العريض في مجموعها، وهو خطّ المواجهة بين أهل الكتاب والثقلين وبها يتجلّى ما بذله هؤلاء الأعداء من جهدٍ وحيلةٍ، ومن مكيدةٍ وخداع، ومن كِذْب ولبسٍ للحقّ بالباطل، وبثّ الريب والشكوك وتبييت الشرّ والضرّ لهما بلا توقّف ولا انقطاع، كما في قوله تعالى: ( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) (١) .
وقوله تعالى: ( مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ... ) (٢) .
وقوله تعالى: ( وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ) (٣) .
وقوله تعالى: ( أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) (٤) .
ومِن المثير في موقفهم هذا أنّهم كانوا ينتظرون بزوغ فجر الدين الجديد، وكانوا يبشّرون به ويفتخرون على غيرهم مِن الأُمم والأديان بأنّ النبيّ المتوقّع
____________________
(١) آل عمران: ٧١.
(٢) النساء: ٤٦.
(٣) آل عمران: ١٨٧.
(٤) البقرة: ٧٥.
سيكون منهم، ولكنْ ما إنْ جاءهم حتّى كفروا به.
قال تعالى: ( وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ) (١) .
ثم إنّهم كانوا يعرفون النبيّ محمّداً (صلّى الله عليه وآله وسلّم) باسمه وبمشخّصاته، ولكنْ بعد أنْ بعثه الله سبحانه لم يؤمنوا به، كما جاء ذلك في قوله تعالى: ( الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ) (٢) .
وقوله تعالى: ( الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) (٣) .
٢ - نقض العهود والمواثيق:
وهُم لا يتّقون... رغم كلّ ما أخذه عليهم أنبياؤهم مِن مواثيق وعهود بضرورة الإيمان بالرسول محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) المبشَّر به في كتبهم وبما يأتي به من كتاب الله.
ومن صريح الآيات في ذلك قوله تعالى: ( الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ ) (٤) .
وقوله تعالى: ( أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ) (٥) .
وقوله تعالى: ( وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا
____________________
(١) البقرة: ٨٩.
(٢) الأنعام: ٢٠.
(٣) البقرة: ١٤٦.
(٤) الأنفال: ٥٦.
(٥) البقرة: ١٠٠.
تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ) (١) .
٣ - النفاق والتضليل:
وما يضلّون إلاّ أنفسهم وما يشعرون... قال تعالى: ( وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ) (٢) .
وقال أيضاً: ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) (٣) .
وقوله تعالى: ( وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلا مَا يُؤْمِنُونَ ) (٤) .
وقوله تعالى: ( أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ) (٥) .
وبهذا الأُسلوب حاول بعضهم جاهدين التوغّل في صفوف المسلمين، عن طريق مؤامرةٍ خسيسةٍ كشفها الله سبحانه وتعالى، وأوضح خطّتها الرامية لزعزعة الإيمان وإخراج المسلمين من عقيدتهم وهي تقوم على أساس التظاهر
____________________
(١) آل عمران: ١٨٧.
(٢) آل عمران: ٦٩.
(٣) المائدة: ٤١.
(٤) البقرة: ٨٨.
(٥) البقرة: ٤٤.
بالإيمان بالرسالة ثُمّ الانسحاب منها بحجّة التوصّل إلى قناعةٍ تامّة ببطلانها وبطلان دعوى النبيّ محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بالنبوّة، قال تعالى: ( وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) (١) .
وعلى نفس النهج يكشف الله تعالى مؤامراتهم الواحدة تلو الأُخرى كالتي يشير إليها قوله تعالى: ( وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) (٢) .
٤ - الحسد والتعصّب:
كأنّهم لا يعلمون... فقد استولت على فريق من أهل الكتاب هذه الحالة الطاغية من الحسد والحقد والتعصب عندما حصحص الحق وبان لهم حدّه، فراحوا يكيدون للثقلين ما وسعتهم المكائد واحتوته نفوسهم المريضة من خداع وتزييف.. ومن الآيات المحكمات التي تسوق لنا هذه الحقيقة هي قوله تعالى: ( وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ ) (٣) .
وقوله تعالى: ( وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ... ) (٤) .
____________________
(١) آل عمران: ٧٢.
(٢) آل عمران: ٧٨.
(٣) البقرة: ١٠١.
(٤) البقرة: ١٠٩.
وقوله تعالى: ( مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ) (١) .
وقوله تعالى: ( وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ) (٢) .
وقوله تعالى: ( وَقَالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) (٣) .
وقوله تعالى: ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلاً ) (٤) .
٥ - التعالي والاستهزاء:
لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون... وهذا أُسلوبٌ آخر تميّز به المُكابرون مِن أهل الكتاب، فهو لغةُ مَن أعيَته السُبل فراح يتخبّط في وهمٍ أغمض فيه عينيه عن الحقائق، هارباً من الحقّ إلى الباطل، تارةً بمسلك العتوّ والاستعلاء وأُخرى بمنطق السُخرِيَة والاستهزاء كما تشير إليه آياتٌ كريمة، منها قوله تعالى في الذين هادوا: ( ... وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيّاً بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ
____________________
(١) البقرة: ١٠٥.
(٢) البقرة: ٨٩.
(٣) البقرة: ١٣٥.
(٤) النساء: ٥١.
لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاّ قَلِيلاً ) (١) .
وقوله تعالى: ( وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِماً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) (٢) .
وقوله تعالى: ( وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ) (٣) .
٦ - الحقد والعدوان:
لبئس ما كانوا يعملون..... مِن صدٍّ عن سبيل الله ومسارعتهم في الإثم والعدوان، بعد أنْ رأوا دين الله يعلو وينتشر وأمرُ نبيّه محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يذيع بين القبائل والأُمم... فأعدّوا العدّة للحرب والعدوان... بِدءاً بمعركةِ النصارى مع المسلمين في مُؤتة، التي استشهد فيها جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة، فمعركة اليرموك وما بعدها...
ومنه ما كان مِن اليهود الذين عُرِفوا بالخيانة ونقض العهود، كالذي حدَث في معركة الأحزاب عندما نقضوا العهد مع النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وتحالفوا مع المشركين ضدّه... وكذا واقعة خيبر التي كانت كانت فيها هزيمتهم الماحقة على يد الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)، وقد عرَضت آياتٌ من القرآن الكريم هذهِ النزعة فيهم... ويظهر هذا الموقف مِن خلال جملةٍ من آيات القرآن كما في قوله تعالى: ( وَتَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا
____________________
(١) النساء: ٤٦.
(٢) آل عمران: ٧٥.
(٣) المائدة: ١٨.
كَانُوا يَعْمَلُونَ ) (١) .
وقوله تعالى: ( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ) (٢) .
وقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ... ) (٣) .
وقوله تعالى: ( فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ) (٤) .
القسم الثاني
الآيات المرشدة للرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) والمسدّدة له في اتّخاذ الموقف الإلهي مِن سلوك ومواقف أهل الكتاب. ولعلّ أبرز عناوينها التي تحدّد تلك المواقف الإلهيّة هي:
١ - دعوة أهل الكتاب وترغيبهم فيه:
قد جاءكم من الله نورٌ وكتابٌ مبين..... ففي الآيات التالية حكايةٌ وبيانٌ بليغ لذلك.
قال تعالى: ( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ) (٥) .
وقال تعالى: ( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ
____________________
(١) المائدة: ٦٢.
(٢) المائدة: ٥٩.
(٣) التوبة: ٣٤.
(٤) النساء: ١٦٠.
(٥) المائدة: ١٥.
الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) (١) .
٢ - التحاجّ إلى الحقّ:
فانْ تولّوا فقولوا اشهدوا بأنّا مسلمون..... وصريح هذا الموقف الإلهي للرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) نجده في قوله تعالى: ( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ) (٢) .
وقوله تعالى: ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ) (٣) .
وقوله تعالى: ( أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ) (٤) .
وقوله تعالى: ( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ... ) (٥) .
وقوله تعالى: ( هَا أَنْتُمْ هَؤُلاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) (٦) .
____________________
(١) المائدة: ١٩.
(٢) آل عمران: ٦٤.
(٣) آل عمران: ٢٣.
(٤) الأنعام: ١١٤.
(٥) المائدة: ٦٨.
(٦) آل عمران: ٦٦.
وقوله تعالى: ( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ) (١) .
٣ - الردّ على شُبهاتهم:
ثُمّ ذرهم في خوضهم يلعبون..... وآيات هذا الموقف كثيرة، منها قوله تعالى: ( وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُوراً وَهُدىً لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ) (٢) .
وقوله تعالى: ( وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَاناً وَكُفْراً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَاراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ) (٣) .
وقوله تعالى: ( وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْداً فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ) (٤) .
٤ - كشف نواياهم وامتحان مدى صدقهم:
والله أعلم بما كانوا يكتمون..... كما في قوله تعالى: ( وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ) (٥) .
____________________
(١) آل عمران: ٧٠.
(٢) الأنعام: ٩١.
(٣) المائدة: ٦٤.
(٤) البقرة: ٨٠.
(٥) المائدة: ٦١.
وقوله تعالى: ( الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) (١) .
وكذا قوله تعالى - في امتحان مدى صدقهم -: ( قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) (٢) .
٥ - إنصاف طلاّب الحق منهم:
أُولئك لهم أجرهم عند ربهم.... كما في قوله تعالى: ( وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ) (٣) .
وغالباً ما يكون هؤلاء من المنتظرين بإخلاصٍ وصدق، لبعثة الرسول بالرسالة الإسلاميّة الموعودة، ويدلّ على ذلك قوله تعالى: ( لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ... ) (٤) .
وقوله تعالى: ( الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ) (٥) .
٦ - رفض ولايتهم:
ومن يتولّهم منكم فإنّه منهم.... فقد جاء في الخطاب الإلهي للمؤمنين قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
____________________
(١) آل عمران: ١٨٣.
(٢) الجمعة: ٦.
(٣) آل عمران: ١٩٩.
(٤) النساء: ١٦٢.
(٥) القصص: ٥٢.
بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) (١) ، وكذلك قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ) (٢) .
وأيضاً في قوله تعالى: ( وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ) (٣) .
٧ - احترام العهود والمواثيق معهم:
إنّ الله يحبّ المتّقين... وبيان ذلك مِن خلال شمول إطلاق المشركين لأهل الكتاب في قوله تعالى: ( إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ) (٤) .
وقوله تعالى: ( .... إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ) (٥) .
وكذلك في خطاب الله سبحانه لبني إسرائيل في قوله تعالى: ( يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ) (٦) .
٨ - الحذر من إغوائهم وتضليلهم:
إنّ الله يعلم ما يُسرّون وما يُعلنون... ويظهر لنا هذا المعنى مِن خلال سياق
____________________
(١) المائدة: ٥١.
(٢) المائدة: ٥٧.
(٣) المائدة: ٨١.
(٤) التوبة: ٤.
(٥) التوبة: ٧.
(٦) البقرة: ٤٠.
آياتٍ كريمةٍ في قوله تعالى: ( أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ * وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ * أَوَلا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ) (١) .
وكذلك في قوله تعالى: ( وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ ) (٢) .
وأيضاً قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ) (٣) .
٩ - التهديد والوعيد للمعاندين منهم:
فإنّ الله سريع الحساب... وفي هذا نجد مجموعةً مِن الآيات الكريمة صريحةً في بيانها، شديدةً في مدلولها، كما في قوله تعالى: ( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآَيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ) (٤) .
وأيضاً قوله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (٥) .
وقوله تعالى: ( فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ
____________________
(١) البقرة: ٧٥ - ٧٧.
(٢) البقرة: ١٤٥.
(٣) آل عمران: ١٠٠.
(٤) آل عمران: ١٩.
(٥) البقرة: ١٧٤.
عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ) (١) .
وقوله تعالى: ( لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ) (٢) .
١٠ - لعن وقتال المحاربين منهم:
حتّى يُعطوا الجِزية عن يدٍ وهم صاغرون... وهذا صريحٌ مبيّن في قوله تعالى: ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) (٣) ، وكذلك في قوله تعالى: ( هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ ) (٤) .
وهكذا جاءت الآية الكريمة من قوله تعالى: ( وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً ) (٥) .
____________________
(١) البقرة: ٧٩.
(٢) آل عمران: ١٨١.
(٣) التوبة: ٢٩.
(٤) الحشر: ٢.
(٥) الأحزاب: ٢٦.
العداء دائم ما دامت علّته
فمن قوله تعالى: ( وَقَالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) (١) . وقوله تعالى: ( وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ ) (٢) .
نعرف أنّ العلّة الأساسيّة للموقف العدائي لأهل الكتاب مِن ثقليّ الرسالة الإسلاميّة (القرآن الكريم والعترة الطاهرة) قائمة دائمة في محور المواجهة بينهما، وهي عدم رضا أهل الكتاب عن المسلمين وأئمّتهم حتّى يتّبعوا ملّتهم، ولا ينحصر هذا العناد والعداء بمرحلة دون أُخرى، بل يمتد في الأرض ما انتشر الإسلام، ويتزامن عبر العصور مع كل قيامِ شوكةٍ للمسلمين، إلاّ أنّه يتكيّف ويتشكّل بما يُوحيه إليهم شيطانهم من مكرٍ وخديعةٍ وخُبثٍ ووقيعة، وفي مقدّمتها المواجهة الفكريّة والإعلاميّة بكافّة أشكالها وكيفيّاتها...
ومنها ما اصطلح عليه مؤخّراً بالاستشراق... ويبقى موقفنا منهم متقوّماً بنفس ما أرشد إليه القرآن الكريم نبيّنا محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وهو ما استعرضناه في مدخل كتابنا هذا... وفي الفصول التالية سنتناول بشيءٍ من التفصيل هذا الشكل من المواجهة لثقليّ الإسلام وعطاءاتهما الرساليّة للبشريّة.
____________________
(١) البقرة: ١٣٥.
(٢) البقرة: ١٢٠.
الفصل الأوّل
نشأة الاستشراق
* هويّة الاستشراق.
* النشأة والبدايات.
* نشأة الاستشراق والاقتران بالتبشير.
* نشأة الاستشراق بين النَّهج العلمي والاستعداد التبشيري.
* مبدأ الاستشراق اختراق ثقافي لدحر المسلمين في أوربّا.
* الاستعراب أوّلا ثمّ الاستشراق.
* بروز نظريّات الاستشراق الاستعماري.
هوية الاستشراق
تعريف الاستشراق:
يُعرّف الاستشراق اصطلاحاً بأنّه: (العلم باللّغات والآداب والعلوم الشرقيّة)(١) ، والعالم بها يُسمّى بالمُسْتَشْرِق والذي ينحصر مصداقهُ عادةً بالمتخصّص الغربي بتلك العلوم.
ومن خلال الاستقراء الشامل لمّا تمخّض عنهُ الاستشراق فعلاً، نجد أنّ الغالب على ما تناوله من الشرق هو الإسلام معارف وحضارة، وعليه يُمكن بَدواً موافقة المُستشرق الفرنسي الشهير(مكسيم رودنسون) في تعريفه للاستشراق بأنهُ: (اتّجاه علمي لدراسة الشرق الإسلامي وحضارته)(٢) .
وبما أنّ الاستشراق نشأ على يد الأوربّيّين، لذلك كان متماشياً ومتناسباً مع طبيعة الفكر الأوربّي في كلّ مرحلةٍ من مراحلهِ التاريخيّة، وكذلك منسجماً مع نظرة أوربّا إلى الشرق وبالخصوص الشرق الإسلامي، فعندما كانت الطبيعة التبشيريّة هي السمة البارزة للفكر والحكومات الأُوربيّة كان الاستشراق يندفع بهذا الاتجاه، ويتأكّد هذا إذا كان المستشرق ينطلق في عمله من خلال مؤسّسة تبشيريّة، حينئذٍ سيأخذ الاستشراق مساراً وحركةً ذات اتجاهاً تبشيريّاً وليس علميّاً محضاً، فيمتد عمل المُستشرق ليشمل كلّ ما يخدم مهمّة التبشير، فهو
____________________
(١) المنجد - مادّة (شرق).
(٢) رودنسون، مكسيم، حوار تحت عنوان (الاستشراق في الميزان)، مجلّة رسالة الجهاد، العدد ٧٠.
عندما يتناول الإسلام فكراً وحضارة بالبحث والدراسة، سيكون ذلك على ضوء ما تمليه عليه طبيعة الفكر التبشيري... ويشير إلى ذلك المُستشرق(در منغهام) في معرض بيانه عن النفي الكيفي، وإثارة الشكوك في مُعطيات السُنّة النبويّة والتاريخ الإسلامي، من قِبل المستشرقين (ذوي الدوافع التبشيريّة) فيقول: (مِن المُؤسف حقّاً أنْ غالى بعض هؤلاء المتخصّصين - من أمثال (موير، ومرجليوث، ونولدكه، وشبرنجر، ودوري، وكيتاني، ومارسني، وغريم، وغولد صيهر، وغودفروا)، وغيرهم - في النقد أحياناً، فلم تزل كتبهم عاملَ هدمٍ على الخصوص.
ومن المُحزن أنْ لا تزال النتائج التي انتهى إليها المُستشرقون سلبيّةً وناقصة، ولنْ تقوم سيرةٌ على النفي، وليس مِن مقاصد كتابي، أنْ يقوم على سلسلةٍ من المجادلات المتناقضة... ومِن دواعي الأسف أنْ كان الأب (لامانسي) الذي هو مِن أشهر المستشرقين المعاصرين، ومن أشدهم تعصّباً وأنّهُ شوَّهَ كتبه الرائعة الدقيقة وأفسدها بكرهه للإسلام ونبيّ الإسلام، فعند هذا العالِم اليسوعي أنّ الحديث إذا وافق القرآن كان منقولاً عن القرآن، فلا أدري كيف يُمكن تأليف التاريخ إذا اقتضى تطابق الدليلين تهادمهما بحكم الضرورة، بدلاً مِن أنْ يُؤيد أحدهما الآخر؟)(١) .
كما نجد ذلك واضحاً في مجموعة من المجلاّت الاستشراقيّة كمجلّة (العالم الإسلامي) التي يصدرها المُستشرقون الأميركيّون والتي أنشأها(صموئيل زويمر) (٢) في سنة ١٩١١م وتصدر الآن من(هار تفورد) بأميركا ورئيس تحريرها
____________________
(١) در منغهام - حياة محمّد - المقدّمة ص٨ - ١١.
(ومع ذلك فقد وقع در منغهم في نفس الداء ونفث في كتابه هذا سُمّاً ناقعاً ومفاهيماً سيّئةً منكرة عن الإسلام ونبيّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم).
(٢) صموئيل زويمر: (١٨٦٧ - ١٩٥٢م) مستشرق أميركي محرّر مجلّة (عالم الإسلام)، له مؤلّفات عن الإسلام في العالم وعن العلاقات بين المسيحيّة والإسلام، منها(يسوع في إحياء الغزالي) - (القاموس المنجد (في الإعلام).
= كان أحد أعضاء الإرساليّة الأميركيّة العربيّة [التبشيريّة] التي تأسّست عام ١٨٨٩م وقد افتتح مع المُبشّر(جيمس كانتين) أوّل محطّة عمل تبشيريّة لهذه الإرساليّة في البصرة عام ١٨٩١م، ثُمّ تلتها محطّة البحرين التبشيريّة عام ١٨٩٣م، واستمرّ في أداء دوره التبشيري في منطقة الخليج العربي بمشاريع متنوّعة هادفة بهذا الاتّجاه.
(د. التميمي، عبد الملك خلف - التبشير في منطقة الخليج العربي ص٤٥ - ٧٠).
(كنيث كراج) وطابع هذه المجلّة تبشيري سافر، وللمستشرقين مجلّةٌ شبيهة بتلك المجلّة في روحها واتّجاهها العدائي التبشيري، وتحمّل نفس الاسم (العالم الإسلامي) مع العلم أنّ أغلب المحرّرين لمثل هذه المجلاّت هُم مِن المبشّرين، كالقسّيس(ا. ا. الدر) والقسيس(ا. بشوب) والقسّيس(ل. ل. براون) والقسّيس(د. م. دونالدستون) (١) .
وهكذا عندما يكون طابع الفكر الأوربّي السائد هو الطابع الاستعماري (بالمعنى الحديث للمصطلح) فإنْ الاستشراق يندفع بهذا الاتجاه ليخدم كل ما من شأنه تكريس الاستعمار، كتزويد الحكومات المستعمرة بالدراسات والتحليلات الوافية عن الشرق والبلاد المستعمّرة، وكذلك تزيين صورة المُستعمرين، وتبرير مُمارساتهم وإظهارهم بمظهر المُنقذ والمُحرِّر وحامل راية الحرّية والحضارة مثلاً، أو قد يكون المُستشرق عاملاً في إحدى مؤسّسات الدول الاستعماريّة بصورة رسميّة، كأنْ يكون مثلاً مستشاراً لوزارة المستعمرات في هذه الدول، كما هو الحال بالنسبة للمُستشرق الفرنسي(هانوتو) ، الذي كان يعمل مستشاراً لوزارة الاستعمار الفرنسيّة، نجدهُ يتّجه في دراساته الاستشراقيّة إلى كلّ ما يخدم الحركة الاستعماريّة لفرنسا في الشرق، بل يُحاول توظيف رعيلٍ مِن المُستشرقين لهذا الغرض من خلال رسم مناهج بحثهم ودراساتهم الاستشراقيّة من وحي الدوافع الاستعماريّة لبلاد الشرق الإسلامي...
وهكذا يصب الجهد الاستشراقي في الإطار الاستعماري لأُوربّا بشكلٍ
____________________
(١) الدكتور محمّد البهي - الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي.
مباشر أو غير مباشر.
ومن نماذج ذلك ما كتبه(هانوتو) هذا عن المسلمين وعقيدتهم، واضعاً المقترحات الضروريّة في نَظَره لتوجيه سياسة فرنسا في مستعمراتها الإفريقيّة الإسلاميّة تحت عنوان (قد أصبحنا اليوم إزاء الإسلام والمسألة الإسلاميّة)، وقد نشرت جريدة(المؤيّد) في تمام القرن التاسع عشر ترجمة لمقالتهِ هذه، نورد مقاطع منها هي قولهُ: (... في تلك البقعة الإفريقيّة التي أصبحت مقرّ مُلك الإسلام، جاءت الدولة الفرنسيّة لمباغتته.
جاء القدّيس لويس - الذي ينتمي إلى إسبانيا بوالدته - ليضرم نيران القتال في مصر وتونس، وتلاه لويس الرابع عشر في تهديده الإمارات الإفريقية الإسلاميّة، وعاود هذا الخاطر نابليون الأوّل، فلم يوفّق في تحقيقه الفرنسيون إلاّ في القرن التاسع عشر، حيثُ أخنوا على دولة الإسلام التي كانت لا تني في متابعة الغارات على القارّة الأوربيّة، فأصبحت الجزائر في أيديهم مُنذ سبعين عاماً، وكذلك القطر التونسي منذ عشرين عاماً).
(... إذَن فقد صارت فرنسا بكلّ مكان في صِلة مع الإسلام، بل صارت في صدر الإسلام وكبده، حيث فتحت أراضيه وأخضعت لسطواتها شعوبهُ وقامت تجاههُ مقام رُؤسائه الأوّلين، وهي تدير اليوم شؤونهُ وتجبي ضرائبه، وتحشد شبابه لخدمة الجنديّة، وتتّخذ منهم عساكر يذبّون عنها في مواقف الطِعان ومواطن القتال).
(إنّ شعباً جمهوريّ المبادئ (شعب فرنسا) يبلغ عدد نفوسه أربعين مليوناً لا مُرشد لهُ إلاّ نفسهُ - لا عائلات ملوكيّة فيه يتنازعْنَ عن الحكم، ولا رُؤساء يتناولون الرئاسة بطريق الوراثة - هو الذي تقلّد زمام إدارة شعبٍ آخر لا يلبث أنْ ينمو حتّى يساويه في العدد، وهو ذلك الشعب المنتشر في الأرجاء الفسيحة والأصقاع المجهولة، والمُتّبع لتقاليدٍ وعاداتٍ غير التي نقولها ونحترمها... هو الشعب
الإسلاميّ الساميّ الأصل، الذي يحمل إليه الشعب الآري المسيحي الجمهوري الآن مِلح المدنية وروحها!!
ليس الإسلام في داخلنا فقط، بل هو خارج عنّا أيضاً... قريبٌ منّا في(مراكش) تلك البلاد الخفيّة الأسرار،... قريبٌ منّا في(طرابلس الغرب) ، التي تتمّ بها المواصلات الأخيرة بين مركز الإسلام في البحر الأبيض المتوسّط، وبين الطوائف في باطن القارّة الإفريقية، قريبٌ منّا في(مصر) حيثُ تصادمت معنا الدولة البريطانيّة فصادمنا إيّاها في الأقطار الهنديّة، وهو موجود وشائعٌ في(آسيا) ، حيث لا يزال قائماً في بيت المقدِس وناشراً أعلامهُ على (مهد الإنسانيّة مقرّ المسيح)، ويحسب أنصاره وأشياعهُ في قارّات الأرض القديمة بالملايين، وقد انبعثت منهُ شعبةٌ في بلاد الصين فانتشر فيها انتشاراً هائلاً، حتّى ذهب البعض إلى القول بأنّ العشرين مليوناً مِن المسلمين الموجودين في الصين لا يلبثون أنْ يصيروا مِئة مليون، فيقوم الدعاء لله مقام الدعاء(لساكياموني) ، وليس هذا بالأمر الغريب، فإنّه منتشرٌ في الآفاق...).
(لا تظنّوا أنّ هذا الإسلام الخارجي الذي تجمعهُ جامعة فكرٍ واحد، غريب عن إسلامنا (في تونس والجزائر)، ولا علاقة له به؛ لأنهُ وإنْ كانت البلاد (الإسلاميّة) التي تحكمها شعوب مسيحيّة ليست في الحقيقة بـ (دار إسلام) وإنّما هي دار حرب، فإنّها لا تزال عزيزة ومُوقّرة في قلب كلّ مسلم صحيح الإيمان، والغضب لا يزال يحوم حول قلوبهم كما تحوم أنثى الأسد حول قفص جلست فيه صغارها، وربما كانت قضبان هذا القفص ليست متقاربة ولا بدرجة من المتانة تمنعها عن الدخول إليها من بينها).
(يُؤخذ ممّا تقدّم أنّ جراثيم الخطر لا تزال موجودة في ثنيّات الفتوح، وعلى أفكار المقهورين الذين أتعبتهم النَكبات التي حاقت بهم، ولكنْ لم تثبط هِمَمَهُم،
نعم ليس لمقاومتهم رُؤساء يشدّون هذهِ المقاومة، ولكن رابطة الإخاء الجامعة لأفراد العالم الإسلامي بأسره كافلة بالرئاسة... ففي مسألة علاقتنا مع الإسلام تجد المسألة الإسلاميّة والمسألة الدينيّة والمسائل الداخليّة والخارجيّة، شديدة الاتّصال بعضها ببعض، وهذا ما يجعل حلّها صعباً ومتعذّراً، كما سنبيّنهُ).
هذا الدافع (الاستعماري) الذي تجلّى عند المُستشرق الفرنسي(هانوتو) ، خلَق تلك النظرة إلى المسلمين في آسيا وإفريقيا، وهي نفسها التي يحملها المُستعمر الفرنسي والإنجليزي والهولندي عند تعامله مَعَهم وتوجيهه إيّاهم، وبهذا تتّضح سياسة الاستعمار في الشرق الإسلامي مِن خلال توجيه الاستشراق كحركة، وتوسيع مفهومه مِن الإطار العلمي المحض إلى إطار حركة الاستعمار وأهدافه.
وقد لا يكون وراء الاستشراق كحركة دافعٌ واحد يُضاف إلى مُدّعى الدافع العلمي، بل كثيراً ما تجتمع وراءه دوافع متعدّدة تنحو به باتّجاه استيعاب كلّ الأغراض والأهداف المشتركة للقوى الكامنة وراءه، فيندفع في مرحلةٍ تأريخيّة واحدة باتجاهات متعدّدة، هدفها تشويه وتحريف العقائد والمتبنّيات الفكريّة السائدة في الدائرة التي تتناولها دراسات المستشرقين وأبحاثهم، ومثال ذلك ما ذكره لنا الكاتب (أنور الجندي) في معرض بيانه لمخطّطات الاستشراق في ضرب الإسلام والوحدة الإسلاميّة من خلال نظرته إلى مصدر الدين، فيقول:
(حاول الاستشراق فرض مفهومه أنّ الدين ظاهرةٌ اجتماعيّةٌ لم تنزل من السماء، وإنّما خرجت من الأرض، كما خرجت الجماعة نفسها على النحو الذي قال به(دوركايم) (١) ومدرسة العلوم الاجتماعيّة التي يتصدّر لقيادتها الاستشراق اليهودي والتي خضع لها وخُدِعَ بها الكثير من الأسماء اللامعة من الذين تلقّوا
____________________
(١) دوركايم (أميل) (١٨٥٨ - ١٩١٧م): عالم اجتماعي فرنسي، قال: إنّ المجتمع هو مصدر الأحداث الأدبيّة والدينيّة. (القاموس المنجد (في الأعلام).
تعليمهم في أوائل هذا القرن في(السوربون) وغيرها وفي مقدّمتهم(طه حسين) و(محمود عزمي) وغيرهم.
وينظر الاستشراق (والمنهج الغربي كلّه) إلى الأديان جميعاً من خلال مقولة مضلّلة تقول: إنّ الأديان ظاهرة اجتماعيّة وظاهرة مرحليّة تلت مرحلة الوثنيّة، وأعقبتها مرحلة العلم التي لم يَعُد الإنسان أو المجتمع خلالها في حاجةٍ إلى وصاية الدين، وإنّ الأمم الراقية الآن لا تحتاج إلى الدين أصلاً.
ومِن ثمّ فإنّ الاستشراق يمضي إلى التشكيك في قاعدة (عالميّة الإسلام) وختم الرسالة، ويفتح الباب واسعاً أمام دعوات البهائيّة والقاديانيّة في الدعوة إلى وحدة الأديان، كما يشير دائماً إلى ما ترمي إليه الماسونيّة ممّا يطلق عليه دين البشريّة(الهومنيزم).
وهذهِ كلّها محاولات تجتمع عليه مخطّطات الاستشراق الغربي والماركسي والصهيوني، في محاولة إزاحة الإسلام والتشكيك فيه(١) .
من كلّ ما سبق نخلص إلى أنّ الاستشراق كمفهوم، ليس اتّجاهاً علميّاً لدراسة الشرق الإسلامي وحضارته، كما ادّعاه المُستشرق الفرنسي الشهير (مكسيم رودنسون)، بل هو في حقيقته حركةٌ واسعةُ الدوافع والقُوى الكامنة وراءه حتّى استوعب في كثير من مراحله وأدواره أغلب التطلّعات الحضاريّة، لأُوربّا وحركتها الاستعماريّة في الشرق خصوصاً الإسلامي منه.
____________________
(١) الجندي، أنور - مجلّة منار الإسلام العدد ٧ - السنة ١٤ (مخطّطات الاستشراق).
النشأة والبدايات
يرى المُتتبّع الفاحص لما احتوته الكتب والدراسات التي تبحث في تاريخ نشوء الاستشراق، وبداياته التكوينيّة، والأدوار التي مرّ بها، ومن خلال مقارنةٍ بين مضامينها، أنّها غالباً ما تكشف عن وحدة الرأي في طبيعة النشوء وصبغته، من أنّه نشَأ وبَدأ تبشيرياً في روحه وأهدافه، إلاّ أنّهم يختلفون في زمان نَشأته وبدايته بالمعنى المصطلح.
فمنهم من قال: إنّه نشأ في القرن التاسع الميلادي،كالدكتور سمير سلمان (١) .
ومنهم من قال: إنّه نشأ في القرن العاشر الميلادي،كبطرس البستاني (٢) ،ونجيب العقيقي (٣) ،ويوسف أسعد داغر (٤) . ومنهم مَن يعتقد بأنّه نَشأ في القرن الثاني عشر، مِن أمثالرودي بارت (٥) .
أمّا شوقي أبو خليل أُستاذ الحضارة العربيّة الإسلاميّة والاستشراق في كلّية الدعوة الإسلاميّة (فرع دمشق) فيقول: (إنّ بداية الاستشراق الفعلي كانت بعد فشل الحروب الصليبيّة.
لقد غادر لويس التاسع في ٨ أيار (مايو) عام ١٢٥٠م،
____________________
(١) مجلّة التوحيد - العدد ٣٢ - (الجذور التكوينيّة للاستشراق في الأندلس): ١٢٣.
(٢) أُدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث: ٣٤٠.
(٣) المُستشرقون: ١١٠.
(٤) مصادر الدراسات الأدبيّة ٢: ٧٢٣.
(٥) الدراسات العربيّة والإسلاميّة في الجامعات الألمانيّة: ٩.
مدينة دمياط مُتّجهاً إلى عكّا، وكانت صيحته بعد هزيمته: لنبدأ حرب الكلمة فهي وحدها القادرة على تمكّننا من هزيمة المسلمين)(١) .
وبهذا يكون قد وافق ما ذهب إليه محمّد البهيّ مِن أنّ الاستشراق قد نَشَأ في القرن الثالث عشر(٢) ، في حين قد ذهب البعض إلى القول باقتران نشوء الاستشراق بالقرارات التي صدَرت من قِبَل رؤوس السلطات الكنسيّة، التي كانت بيدها مقاليد الأُمور في رسم وتحديد سياسة دُول أوربّا في تلك العصور، فكان اتّخاذ قرار تأسيس عدد من الكراسي لتدريس اللغة العربيّة واليونانيّة والعبريّة والسريانيّة، في جامعات باريس وأكسفورد وبولونيا وأفينيون وسلامنكا، وبعض الجامعات الأوربيّة الأُخرى من قبل مجمع فيَنّا الكنسي عام ١٣١٢م فاتحة لبداية الاستشراق(٣) .
ولكلّ من أصحاب هذه الآراء التي سقناها مستند ودليل يعتمد عليه، إلاّ أنّ الأهم مِن كلّ ذلك هو اتّفاق أغلب الكتّاب عن الاستشراق من المسلمين وغيرهم، على أنّ نشأته كانت تبشيريّة في المحتوى والوسائل والأهداف.
وعليه لابدّ لنا مِن معرفة جذور هذه الصبغة لما لها من تأثيرٍ كبيرٍ في تشخيص مسار حركة الاستشراق، وتحديد الأدوار والمراحل التي مرّ بها، وإرسائها على أُسُس موضوعيّة من واقع النشأة والصيرورة، وصولاً إلى الأهداف الحقيقيّة التي تصبو لها هذه الحركة.
____________________
(١) مجلّة العالم - العدد ٢٤٨ - (الاستشراق والإسلام): ٣٤.
(٢) الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي: ٥٣٢.
(٣) سعيد، أدوارد (الاستشراق): ٦٦.
نشأة الاستشراق والاقتران بالتبشير
نبدأ مسيرنا في البحث عن جذور الاستشراق مِن أوّل ظاهرةٍ تبشيريّة (بالمعنى المصطلح)، والتي قرنت فيما بعد بالاستشراق، متماشين مع مدعى بعض الكتّاب المعاصرين الذين كتبوا عنه، معتمدين على الأدلّة التاريخيّة التي تثبت أنّ نشأته كانت في القرن التاسع الميلادي كما أسلفنا سابقاً، وأنّ وطنه الأُم هو الأندلُس بعد الفتح الإسلامي لها واستقرار المسلمين فيها عام ٧١١م.
ولقد تزامنت هذه النشأة مع بداية تأجّج الصراع بين النصارى الأوربّيّين والمسلمين الأندلسيّين، والذي بَرَز على شكل ظواهر كان أوّلها نشوء حركة الاستشهاد عام ٨٥٠ م بقيادة بعض المسيحيّين المُتطرّفين ورجال الدين آنذاك، من أمثال القدّيس (أولوخيو) أو (أولوجيوس) و(البروقرطبي)، في عهد حكم الخليفة الأموي (عبد الرحمان الأوسط) الملقّب بالثاني، الذي حكم بلاد الأندلس في الفترة ما بين (٨٢٢ - ٨٥٢م)، بعد وفاة والدهالحكم الأول ابن هشام الأوّل ابن(عبد الرحمان الداخل) مؤسّس الدولة الأمويّة في الأندلس، والذي حكمها في الفترة ما بين (٧٥٦ - ٧٨٨م)(١) .
لقد كانت هذه الحركة تحكي في حقيقتها حالة التعصّب المُستعِر في صدور
____________________
(١) د. إبراهيم، حسن (تأريخ الإسلام) ٢: ٢٢٧.
المُستعربين(١) من الذين أثارهم مدى نفوذ الإسلام، وقوّة تأثير الثقافة الإسلاميّة واللغة العربيّة في واقع الشعب الأسباني، فتحرّكوا لمواجهة هذا النفوذ والعمل على تفريغ محتواه من نفوس الأسبان، عن طريق إذكاء حالة العداء الديني وتغذيتها بأشكال الإثارة الحادّة ليتسنّى لهم دقّ إسفين الخلاف، ومِن ثمّ صبّ ذلك في محور تحريضي مباشر تجاه الخلافة الإسلاميّة.
حتّى إنّ بعض المُغالين من الرهبان كان يصرّ على التعرّض للإسلام، والطعن في النبيّ محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، والنيل من المقدّسات الإسلاميّة للفوز بعقوبة الموت، مُعتقدين بأنّهم يكسبون بذلك شرف الشهادة الذي حُرِموه نتيجةً للتسامح الذي كان سِمةً من سِمات حكّامهم المسلمين في دار الخلافة بالأندلس.
وبالرغم من أنّ عدد هؤلاء المتعصّبين لم يكن كبيراً، إلاّ أنّ الحكومة قد خشيت آنذاك (سوء عاقبة هذه الحوادث وأوجست خيفة من أنّ احتقارهم سلطانهم، وعدم اكتراثهم بالقوانين التي سنّوها ضدّ مَن يطعن في دينهم (الإعدام)، قد يؤدّي إلى استفحال روح الكراهيّة، وذيوع حركة العصيان بين الأهلين كافّة)(٢) .
فعمدت إلى القضاء على حركة الاستشهاد، مستفيدةً من اعتدال الكثير من المُستعربين، وعدم تفاعلهم معها.
ولمّا كانت هذه الحركة عبارة عن إرهاص متشنّج يحكي حالة الرفض المتعصّب بطريقةٍ انفعاليّة هيمنت على أفكار المُتديّنين والقساوسة الأسبان - كما عبّر عنها(ريتشارد سوذرن) ووصفها: (بأنّها حركة ضدّ رضا العامّة بالحضارة العربيّة)(٣) - فقد خلقت أرضيّة لعمل فكري يهدف إلى معرفة وفهم
____________________
(١) استعرب: صار دخيلاً بين العرب. (القاموس المنجد، باب: عرب).
(٢) أرنولد، توماس - الدعوة إلى الإسلام - الترجمة العربيّة: ١٦٥ - ١٦٦.
(٣) سوذرن، ريتشارد - صورة الإسلام في أوربّا في العصور الوسطى: ٥٨.
العدوّ الإسلامي، ودراسة سرّ قوّته وتميّزه، ورفع الإبهام عن لغز تفوّقه وقدرته. أي بعبارةٍ أُخرى خلقت أرضيّة الاستشراق بروحه التبشيريّة.
أمّا لماذا لم يتم هذا العمل الفكري في الفترة التي كانت حركة الاستشهاد في أوجّها؟ فيقول (سوذرن): (إنّ كلاً من (أولوجيوس) و (ألبرو قرطبي) قائدَيّ الحركة كانا يعتقدان أنّ السيطرة الإسلاميّة هي بداية المقدّمة الضروريّة لظهور المسيح الدجّال، المذكور في كتبهم المقدّسة، وانسجم ذلك مع تأويلات خاطئة باقتراب يوم القيامة، وعلائمه التي كانت سائدة بين أوساط المجتمع الأوربّي المسيحي آنذاك.
إضافةً إلى أنّهما لم يكونا مؤهّلين للجهد الفكري المطلوب في معرفة وفهم العدوّ الإسلامي، كما وإنّهما - القائدَين - وأتباعهما لم يكونوا يريدون أنْ يعرفوا شيئاً)(١) لتَشبُّع قلوبهم بالبغض والكراهيّة والغضب على كلّ ما هو مُخالف لأفكارهم ومعتقداتهم الخرافيّة السائدة، وتأويلاتهم المنحرفة التي ما أنزل الله بها من سلطان.
ولم تكن الكنيسة الكاثوليكيّة بأحسن حالاً من هؤلاء، حيث لم تخرج عن دائرة هذا الجوّ العدائي.
فقد كانت أحد العوامل الرئيسيّة لتأجيج الصراع وتغذية الشعور المعادي للمسلمين، وإذكاء نار الحقد في صدور رعاياهم ضدهم بكلّ ما تهيّأ لها من وسائل وأُوتيت من قوّة، لما أدركته من تأثير الإسلام وسرعة نفوذه وكثرة المُقبلين عليه.
حيث يصف أحدُ المؤرّخين هذه الظاهرة فيقول: (بأنّ تأثّرهم بالإسلام كان بمحض إرادتهم في أغلب الأحيان)(٢) . وأخذت الكنيسة الكاثوليكيّة تدرك تدريجياً ومن موقع دفاعي ضرورة إعطاء النصارى أسباباً
____________________
(١) سوذرن، ريتشارد - صورة الإسلام في أوربّا في العصور الوسطى: ٥٩.
(٢) بروفنسال، ليفي (حضارة العرب في الأندلس) الترجمة العربيّة: ١٦ - ١٧.
وجيهةً ليحافظوا على إيمانهم التقليدي الخاص، ويتحصّنوا داخله.
إلاّ أنّ هذه المساعي لم تنجح، فسرعان ما تأجّجت العصبيّات واستفحل العداء الشديد.
وعلى هذا نرى أنّ بدايات الاستشراق لم تكن منفصلة عن منظومة التنصير والتبشير، ولا عن الدوافع الدينيّة المتطرّفة التي كانت الأساس في نشأة الفهم الاستشراقي(١) ، فلا عجب إذن إذا رأينا الكثير من المُستشرقين يجهدون في تصوير العالم الإسلامي في كتاباتهم على أنّه بشعٌ في عاداته، قبيحٌ في أخلاقه، مليء بالبِدَع والانحرافات عن الدين السماوي الحقّ الذي جاء به المسيح النبيّ، ولا يتحرّزون عن اختلاق ما يدعم دعواهم تلك، وكلّ ما مِن شأنه زرع روح التشكيك في الإسلام وزعزعة اليقين بين أوساط المسلمين.
____________________
(١) راجع د. سلمان، سمير (الجذور التكوينيّة للاستشراق في الأندلس) مجلّة التوحيد - العدد ٣٢: ١١٦.
نشأة الاستشراق بين النهج العلمي والاستعداء التبشيري
إنّ البدايات التي سجّلها الباحثون لنشأة الاستشراق لم تكن خارجة عن نطاق الصراع الذي تربّع أبطاله على صدر الأندلس، وتركوا آثار حقدهم وتعصّبهم شاخصةً على مرّ العصور، مُنزِلةً الضربة تلو الأُخرى بالوجود الإسلامي في الأندلس.
فالحرب التي شنّتها المسيحيّة على الإسلام حينذاك قد نحَت مَنحَيَيَن باتّجاهين مُتوازيين يعضد أحدهما الآخر، ويؤدّيان إلى هدفٍ واحد، ألا وهو القضاء على الخصم الذي غزاهم وهُم غارقون في سُباتٍ عميق.
الأوّل: كان يُريد تحقيق هذا الهدف بحدِّ السيف وإعلان الحرب المباشرة، لاجتثاث جذور الوجود الإسلامي بشكل سريع ونهائي.
والثاني: كان يرى أنّ دراسة العدو، واستثمار معارفه وعلومه، والاطلاع على مبادئه وأفكاره يشكّل الطريق السليم لمواجهة هذا العدوّ من خلال امتلاك سرّ قوّته، ومعرفة سُبل اجتثاثه من داخله.
إنّ الاختلاف الظاهري لهذين الاتّجاهين المعاديين للإسلام والذي أُريد له أنْ يبرز بشكلٍ مقصود، كان يُعبّئ الآخرين ويبرز ردود فعلٍ موسومةً بالتصلّب والتعدّي تارة، وبالمرونة وطَرقِ السُبل السلمية بغطاءِ العلم والمعرفة تارةً أُخرى.
إنّ ما قام به أسقف طُلَيطَلة مِن إخضاع النصارى الأسبان له، إثر تعرّض
العلاقات والروابط بين الكرسي البابوي من جهة، والكنيسة من جهةٍ أُخرى للضعف والتردّي، أدّى إلى انفصال الأخيرة عن البابويّة، ممّا حدا بأسقف طُلَيطلة إلى إخراج ترجمات مبكّرة لبعض الكتب العلميّة العربيّة(١) .
وكما ذكر غابريلي في(تراث الإسلام) : (لقد استعربت المسيحيّة بسرعة لغويّاً وثقافيّاً)(٢) .
في الوقت الذي استمرّت الكنيسة على تصلّبها وأبرزت تعصّباً بالغ التزمّت تجاه أيّ تقاربٍ ومهادنة أو موقفِ صداقةٍ تفرضه الطبيعة العلميّة، أو ظروف التقارب الثقافي الذي قد يتّخذه بعض طلاب الثقافة والمعرفة الأوربيّين من الإسلام والثقافة الإسلاميّة.
ومِن أمثلة ردود الفعل المتعصّبة التي أفرزتها طبيعة الخلافات هذه، هو ما أعلنه البابا(غريغور التاسع) من أنّ فريدريك الثاني حاكم صِقلْيّة الذي أصبح إمبراطوراً لألمانيا في عام ١٢٢٠م قد خرج على الكنيسة، حيثُ كان(فريدريك) هذا مُستعرباً لغةً وثقافةً وعلوماً وعادات.
وقد أهدى كتباً فلسفيّة تُرجمت عن العربيّة إلى جامعات بولونيا وباريس، وعندما أصبح إمبراطوراً أسّس جامعة في نابولي سنة ١٢٢٤م، وجعل منها أكاديميّة لنقل المعارف الإسلاميّة إلى العالم الغربي(٣) .
وعليه فإنّ نشأة التبشير في الأندلس بدأت بهدف القضاء على الإسلام، والتبشير للمسيحيّة بين صفوف المسلمين الكَفَرَة - كما كانوا يسمّونهم - الذين قدموا من بلاد العرب وفتحوا الأندلس، أو الذين دخلوا الإسلام حديثاً والذين يطلق عليهم (المولدين)(٤) ، بعد أنْ ثبت لدى أغلب رجال الفكر
____________________
(١) زقزوق، محمود حمدي (الاستشراق والخلفيّة الفكريّة للصراع الحضاري): ٢٤.
(٢) غابريلي، فرانشسكو (تراث الإسلام) - القسم الأوّل - الترجمة العربيّة: ١٣٤.
(٣) رودنسون، مكسيم (جاذبيّة الإسلام) الترجمة العربيّة: ٣٢ و٣٣.
(٤) أُطلقت هذه التسمية على أبناء الأندلس القُدماء الذين انحدروا مِن آباء أسبان، وهؤلاء كانوا يمثّلون طبقة اجتماعيّة واسعة من المجتمع الأندلسي، دخلوا الإسلام أثناء الفتح، وحَسُن إسلام الكثير منهم. وكان منهم من أصحاب التآليف والتصانيف والمكانة العلميّة المرموقة. عن مجلّة نور الإسلام: ٢٧ - ٢٨/ (العصبيّات وآثارها في سقوط الأندلس).
النصارى وعلمائهم أنّ الإسلام لا يُمكن القضاء عليه بالعمل العسكري، فدون ذلك خرط القتاد، وأنّ أيّ مواجهة سوف لنْ تثمر شيئاً ومحكومٌ عليها بالفشل والخُسران.
لذا فإنّ منظومة التبشير والتنصير قد تولّدت في أُتون الصراع المُستعِر بين الإسلام والكنيسة على الأرض الأندلسيّة، والتي شكّلت مُنذ القرن التاسع عشر الميلادي الخليّة الأولى في مشروع الاختراق الثقافي الأوربّي للوجود الإسلامي، تمهيداً للامتداد والسيطرة الاستعماريّة وبنشاطٍ منظّم.
فالتبشير مصطلحاً ونظريّة، يقوم على نشر المسيحيّة في جميع بقاع الأرض التي تخلو منها، وهو بمعنى آخر هجوم المسيحيّة على الديانات الأُخرى بهدف اقتلاعها مِن عقول ونفوس معتنقيها، والحلول محلّها بكلّ وسيلة (سلميّة) ممكنة، وتطرق في ذلك أبواباً شتّى للوصول إلى أهدافها، منها: معرفة لغة الناس المقصودين بالتبشير، ودراسة عاداتهم وقِيمهم ومعتقداتهم عن كثب، والتدخل (للمساعدة) في حلّ مشاكلهم الشخصيّة والاجتماعيّة والصحيّة(١) .
مستفيدين من حالة الجهل والأُميّة السائدة في أوساطهم، للتشكيك في عقائدهم كمقدّمة لزقّهم بالتعاليم النصرانيّة عن طريق مؤسّسات التربية والتعليم، كالمدارس والمعاهد والجامعات وأمثالها.
وهكذا بدأ التبشير حركتهُ الشاملة للقضاء على الوجود الإسلامي، متّخذاً صوراً وأشكالاً مختلفة، وكان الاستشراق أبرز صوره الفكريّة. وهكذا كان العلم والبحث العلمي الذي يفترض فيه سموّ الإنسان بتحصيله المتواصل للكمالات قد
____________________
(١) الطهطاوي، محمّد عزت إسماعيل (التبشير والاستشراق): ١ - ٣.
استُخدِم أداةً مِن أدوات التخريب الحضاري لبلاد المسلمين، والاعتداء على تراثهم، والطعن بالباطل في دينهم. وكانت المآرب السياسيّة والتعصّب للدين من السمات الأساسيّة للحركة الاستشراقيّة، ومن العناوين الخفيّة للوحدة والانسجام بين الاستشراق والتبشير.
مبدأ الاستشراق اختراق ثقافي لدحر المسلمين في أوربّا
لقد كان الصراع التدميري الذي خاضته الكنيسة ومن ورائها المستعربون المتعصبون من النصارى ضد المسلمين في الأندلس والذي برّز الاستشراق صورةً من صوره الفكريّة فيما بعد قد اتّخذ مسارين: الأوّل ديني، والثاني فكري وسياسي.
أوّلاً: المسار الديني:
يُمكن تلخيص الكاشف عن المسار الأوّل بما يلي:
أ - سعي الكنيسة الدائب لاسترداد أسبانيا مِن المسلمين وإعادتها إلى سلطتها، وأنّ تلكّؤ مساعيها في النجاح لا يعني هزيمتها، فحروب الأسبان (القدماء) كانت خاضعة للكرّ والفرّ، واستمرّت بأشكالٍ مختلفة، مِن حربِ عصاباتٍ إلى مناوشاتٍ مشحونةٍ بالعداء الديني، إلى تأجيج العصبيّات بصيغتها الدينيّة بين مختلف الطوائف والقبائل، حتّى استنزفت قُوى الدولة الأندلسيّة التي ما لبث التفكّك والتشرذم أنْ طال كيانها الناشئ، في الوقت الذي لم تحسم فيه المواجهة بين الطرفين المُتصارعين، واستمرّت تتناوب بين انكفاءٍ وتقدّم.
وبدءاً بعام ٧٥٦م راحت الهَجَمَات الأسبانيّة تتوالى حتّى (أخذت شكلاً تكتّليّاً وحرباً مقدّسة صليبيّة بآخر المعاقل الإسلاميّة)(١) .
وهكذا استمرّ الحال حتّى سقوط غرناطة بأيدي الأسبان، ووصول الوجود الإسلامي في الأندلس إلى نهايته عام ١٤٩٢م بعد أنْ تواصل ثمانية قرون تقريباً.
ب - إنّ من جملة أسباب تفوّق الأسبان الأُوربّيّين في هذه الحرب هو أنّهم (استعاروا أُسلوب المسلمين في الجهاد المقدّس)(٢) فأفادت المسيحيّة الأسبانيّة من عقيدة خصمها، وخاضت غمار المواجهة بأحد أمضى أسلحة الخصم الإسلامي، وأنشأت (طوائف الفرسان الدينيّة في سانتياغو وكلاترافا وألكنترا، وفي الطوائف التي ذاع صيتها في السجلاّت التأريخيّة لحروب الاسترداد)(٣) . علماً (بأنّ الأُسلوب نفسه قد اعتمدته الحملات الصليبيّة أيضاً)(٤) .
ج - لقد ترك الصراع الذي خاضته الكنيسة ضدّ المسلمين في الأندلس آثاره على مسير الكاثوليكيّة الأسبانيّة، وجنَت منه فوائداً كبيرةً، منها تحوّل هذا الصراع إلى عامل أساسي في بناء أسبانيا، وتطوير تركيبتها الداخليّة الخاصّة وموقعها العام، خصوصاً على مستوى الحسّ الديني المُرهف الذي برز عند الأسبان أفراداً ومجتمعاً، مِن خلال ما تركته العلوم والآداب الإسلاميّة مِن آثار في أعماق وأُسُس الحضارة الأسبانيّة مُنذ العصور الوسطى وإلى يومنا هذا.
____________________
(١) زقزوق، محمود حمدي - (الاستشراق والخلفيّة الفكريّة للصراع الحضاري) مؤسّسة الرسالة، بيروت، ط٢، ١٩٨٥م.
(٢) لومبير، إيلي - (تطور العمارة الإسلاميّة في أسبانيا والبرتغال وشمال إفريقيا) الترجمة العربيّة: ١٤٤.
(٣) بروفنسال، ليفي - (حضارة العرب في الأندلس) الترجمة العربيّة: ١٦ و١٧.
(٤) قنواتي، جورج شحاته - (تراث الإسلام) القسم الثاني، الترجمة العربيّة: ٢٦٠.
ثانياً: المسار الفكري والسياسي:
إنّ أبرز العوامل التي بلورت هذا المسار هي:
أ - إنّ النصارى مِن غلاة رجال الكنيسة والمُستعربين الأُوربّيّين الخاضعين للحكم الإسلامي، كانوا ينظرون إلى المسلمين على أنّهم محتلّون برابرة كَفَرة، ويحرّضهم على ذلك الشعور تعصّبهم الديني وجشعهم السياسي، وشهوة مُلوكهم التائقين إلى استرداد ما فقدوه بالقوّة عند الفتح الإسلامي.
ب - إنّ بعض الأُمراء الأمويّين لم يعملوا على إخضاع جميع المواقع المسيحيّة لحكمهم في شبه جزيرة أيبيريا، ممّا أعطى للأسبان فرصةً سانحةً في أنْ ينطلقوا لإثارة الحروب والفتن.
ج - السياسة غير الحكيمة التي مارسها أحياناً بعض الأُمراء الأمويّين ضدّ المُستعربين، وضدّ غيرهم مِن طوائف المجتمع الأندلسي كالصقالبة(١) ، والبربر(٢) ،
____________________
(١) الصقالبة: هم عند مؤرّخي العرب الشعوب السلافيّة القاطنة بين جبال الأورال والبحر الأدرياتيكي، وهُم من أُصول أوربيّة مختلفة، وينقسمون إلى قسمين: الأوّل منهم صقالبة الشمال (الروس والروس البيض والبولونيون)، وصقالبة الجنوب أو اليوغسلافيون (الصرب والكرواتيون والسلوفاكيون والبلغاريون).
وقد جيء بهم إلى الأندلس أطفالاً صغاراً ذكوراً وإناثاً، فنشأوا نشأةً عربيّة إسلاميّة في بلاط الملوك والحكّام. كان منهم العبيد المجنّدون في الخدمة العسكريّة، ومنهم القادة والكتّاب والأُدباء.
القاموس (المنجد في الأعلام) وكذلك مجلّة نور الإسلام، العددان ٢٧: ٢ و٢٨: ٣٤ من (العصبيّات وآثارها في سقوط الأندلس).
(٢) البَربَر: اسم يطلق على سكّان إفريقيا الشماليّة من برقة إلى المحيط، كانوا يتكلّمون لهجات أعجميّة قبل استعرابهم، ولا يزالون. ويرجع أصلهم إلى فِئات عرقيّة مختلفة استقرّت في البلاد قبل الميلاد، وعرفت بعض الازدهار مثل:(مملكة نوميديا ومملكة موريتانيا) .
لم يكونوا مرتاحين تماماً إلى حكم روما ولا إلى أسبانيا بقيادة أحدهم وهو طارق بن زياد، تبعوا الخوارج وأعلنوا العصيان على العباسيّين. توزعوا ممالك وسلالات، فكان منهم الأغالبة والرستميّون والمرابطون والموحّدون، ثمّ زالت دولتهم في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي، وقد تحمّلوا القسم الأعظم مِن أعباء الفتح فقتل منهم في هذا السبيل الآلاف، وقد تأثّروا كثيراً بالدين الإسلامي، وأبدوا تحمّساً لنشره والدفاع عنه.
عن القاموس (المنجد في الأعلام) وكذلك مجلّة نور الإسلام، العددان ٢٥: ١ و٢٦: ٨ في = (العصبيّات وآثارها في سقوط الأندلس).
والمولدين، ممّا أدّى إلى تنامي الشعور القومي والحساسيّة العرقيّة لدى المواطنين من قدامى الأسبان، وكذلك الذين استعربوا، فكانت مناطقهم مركزاً للمقاومة من قدامى الأسبان، وكذلك الذين استعربوا.
فكانت مناطقهم مركزاً للمقاومة العسكريّة النصرانية، ممّا سهّل لهم لعب دورٍ كبيرٍ لخوض حرب إيديولوجيّة سياسيّة.
د - بروز أجواء متوتّرة ساعدت على اعتماد القمع العنصري والقبلي، من قِبل الحكّام كَرَدّة فعل على الاضطرابات والأجواء المشحونة بالقلاقل، والتي كانت مدعومةً أحياناً من النصارى والمُستعربين والمُتعصّبين.
هـ - بروز صراعات سياسيّة وقبليّة بين المسلمين العرب أنفسهم، منها العصبيّة التي ثارت بين القيسيّين واليمنيّين، وأخذت العرقيّة القبليّة تنبض في نفوس أصحابها، فتطاحنوا (وتذابحوا وذهبت ريحهم)(١) . فانتهز المتربّصون بالحكم الإسلامي، والذين يصطادون في الماء العكر من نصارى الأسبان الفرصة للعصيان وإشعال فتيل الفتن والاضطرابات والتهيّؤ للمستقبل، الذي يأملون فيه القضاء على الحكم الإسلامي في الأندلس. فتدافعوا وجمعوا قواهم، واستعدّوا.
و - الدعم المباشر الذي قدّمه بهذا الاتّجاه النصارى الأوربّيون من الفرنسيّين وغيرهم بقيادة شارلمان (٧٤٢ - ٨١٤م) المعروف بتصدّيه التاريخي للانتشار الإسلامي في أوربّا، تمّ بمباركة البابا (أُوربانس الثاني) - الذي تسبّب فيما بعد بتأجيج الحروب الصليبيّة - عبر النداء الشهير الذي أطلقه في ٢٧ تشرين الثاني عام ١٠٩٥م، ودعا فيه نصارى أوربّا إلى الجهاد ضدّ الكَفَرَة المسلمين، وحمل السلاح لغزو الشرق، وهو نفسه الذي أعدّ حملةً مؤلّفةً في معظمها من (فرسان جنوب فرنسا) عام ١٠٨٩م لمساعدة نصارى الأسبان في مقاتلة
____________________
(١) بالنتيا، أ. جـ (تأريخ الفكر الأندلسي) الترجمة العربيّة: ١٧.
المسلمين في الأندلس(١) .
ز - الدور الذكيّ والمُخادع الذي لَعِبهألفونس الثالث (٨٦٦ - ٩١٠م) ملك أشتوريش وليون الاسباني في العمل الجاهد لاختراق المسلمين في الداخل ونشر الفرقة بينهم، حتّى نجح في استمالة المُستعربين الذين أسلموا حديثاً، مستنفراً فيهم كوامن المذهبيّة والطائفيّة، ممّا حداهم إلى رفض الإسلام والتمرّد على السلطة المركزيّة في قرطبة (ووعدهم بمنحهم الاستقلال إذا انقلبوا في اللحظة الحاسمة، ووقفوا إلى جانبه في موعد الهجوم على ضواحي قرطبة ومناطقها الشماليّة، وذلك مِن أجل أنْ يعيشوا أحراراً في أرضهم التي انتزعها المسلمون منهم بالعنف.
وإنّ وعدهم نصرتهم الملك، تعني استمرارهم كوسائل اقتصاديّة فقط، وكمصدر لإغناء خزينة الخلافة الإسلاميّة)(٢) .
وهكذا كانت عمليّة اختراق الوجود الإسلامي مِن قبل المُستعربين في الأندلس قد تمّت من زاويتين رئيسيّتين:
الأولى: بشريّة تشكل قوّة عسكريّة كبيرة العدد مدعومةً بالقوّة الأوربّية قادرة على ترجيح الكفّة من الناحية الإستراتيجيّة للمسيحيّة.
الثانية: إيديولوجيّة حضاريّة، وهي مدار بحثنا هذا، وهي الأهم والتي يُمكن أنْ يلعب مِن خلالها المُستعربون دوراً كبيراً في تقويم أوربّا الرازحة تحت وطأة التخلّف الحضاري، والخواء الثقافي، ورفدها بالمعارف والعلوم الحيويّة لنهضتها المخطّط لها. ثمّ إنّ دورهم هذا هو دينٌ عليهم وردٌ للجميل الذي قدّمته أوربّا لهم بمساعدتها لضرب الحكم الإسلامي.
وقد بذلت الكنيسة ومؤسّساتها كامل الجهد لاستيعاب كل هذه الأهداف
____________________
(١) لومبير، ايلي - (تطور العمارة الإسلاميّة في إسبانيا...) الترجمة العربيّة: ١٤٤.
(٢) بروفنسال، ليفي - (حضارة العرب في الأندلس) الترجمة العربيّة: ٧٩.
في تخطيطٍ شاملٍ، وبرعاية السلطة السياسيّة وتشكيلاتها.
وهكذا كان، فقد ابتكرت الكنيسة حرباً جديدة ومواجهة غير مرتقبة، سلاحُها العلم والفكر واغتنام المفردات الحضاريّة للمسلمين، وتكييفها بالشكل الذي يسدُّ نقصهم وثغراتهم الأيديولوجيّة، ويمنحهم القدرة للتفوّق في هذا الجانب الأساسي على العدوّ الإسلامي. فبعد أنْ كان النصارى الأسبان يتخبّطون في ظُلمات جهلهم إبّان الفتح الإسلامي، ضُعفاء لا يملكون أسباب القوّة للردّ والمواجهة، أدركوا الآن قانوناً أساسيّاً من قوانين مقارعة الخصم والذي يتمثّل في معرفة الخصم وفهم حقيقته، وذلك عن طريق اكتشاف عوامل كماله ونقصه، وأسباب قوّته وضعفه، ومواطن ذلك في وجوده، ومن الذي يكمن وراء تفوّقه وهيمنته. وخلال دورة زمنيّة لم تطل كثيراً استطاعوا بإتقان أنْ يصلوا إلى أهدافهم، ويستحوذوا على كافّة مستلزمات المواجهة الشاملة لدحر المسلمين.
وفي طليعة انجازاتهم هذه:
أ - ما قام به الرُهبان مع بداية القرن التاسع من تعلّم اللغة العربيّة الفصحى، ومن ثمّ الإقبال على الترجمة عنها، وذلك (بناءً على تعليمات أساقفتهم)(١) . كما
____________________
(١) إنّ أوّل ترجمة (مزعومة) للقرآن يرجع تأريخها إلى عام ١١٤٣م، عندما أنهى إنجليزي وهو(روبرت الكتوني) بين ١٦ أيار و٣١ كانون الأوّل، من العام المذكور ترجمة لبعض معاني القرآن من العربيّة إلى اللاتينيّة، واستناداً إلى فهمه الشخصي. وكان هذا الرجل قد تنقّل في بعض البلدان الآسيويّة قبل انتقاله إلى برشلونة عام ١١٣٦م. وقد كانت ترجمته هذه بالإضافة إلى ترجمة كتب أُخرى من العربيّة إلى اللاتينية قد نمت تحت إشراف ورعاية أحد الأساقفة، وهو(بطرس الموقر) رئيس دير(كلوني) الفرنسي، وهو الدير الذي تخرّج منه البابا (أُوربانس الثاني) مؤجّج الحروب الصليبيّة. وكان الموقر هذا يرى في الإسلام خطراً فكريّاً شديداً على المسيحيّة لابد من التعرّف عليه لتمكن مكافحته بغير الوسائل العسكريّة.
راجع ما يلي:
خدابخش، صلاح الدين - (حضارة الإسلام) الترجمة العربيّة: ٤١ - ٤٢. وكذلك سوذرن، ريتشارد. (صورة الإسلام في أوربّا في العصور الوسطى): ٨٠ - ٨٢.
جاء على لسان المُستشرق(فرانز روزنتال) بقوله: (وبتعلّم اللغة العربيّة باعتبارها لغة العلوم والفلسفة والفكر آنذاك، وبالاطلاع على القرآن وترجمته إلى اللاتينيّة، بهدفٍ وحيد وهو الوصول إلى فهمٍ عميق للتفكير الديني الكلامي عند المسلمين، أملاً في أنْ يُصبح الرهبان أقدر على التعرّف على هذا التفكير، واستغلال ما كانوا يتصوّرون أنّه مواطن الضعف فيه)(١) .
ب - قيام القساوسة والرهبان الأوربّيون، وكذلك الأسبان بحملةٍ ضخمةٍ لترجمة الفكر والثقافة الإسلاميّة وعطاءاتها الحضاريّة الإنسانيّة، وبذلك تمكّنوا مِن تأسيس أوّل شبكة إيديولوجيّة للاستشراق الغربي، مستهدفين بذلك مقاومة الإسلام ومحاصرته سياسيّاً وفكرياً وعقائديّاً بعيداً عن أيّ هدفٍ علمي منزّه(٢) ، واضعين نصب أعينهم إعادة المجد التليد، والبريق القديم الذي فقدته النصرانيّة هدفاً لهم، مخطّطين لحملاتٍ ضخمةٍ للتنصير، عبر منهجَين متضادَين ومتوازيَين ظاهريّاً: أحدهما علمي يستند إلى البحث والدراسة بقصد المعرفة والكشف، والآخر سياسي تطويقي يهدف إلى تدمير وتصفية الخصم بأيّ وسيلةٍ ممكنة. وبذلك تتوظّف كلّ الجهود العلميّة والسياسيّة لتحقيق الهدف التنصيري.
ويشهد على ذلك قول(رودي بارت) : (كان موقف الغرب المسيحي في العصر الوسيط من الإسلام هو موقف الدفع والمشاحنة فحسب. صحيح أنْ العلماء ورجال اللاهوت في العصر الوسيط كانوا يتّصلون بالمصادر الأُولى في تعرّفهم على الإسلام، وكانوا يتّصلون بها على نطاق كبير، ولكن كلّ محاولةٍ لتقويم هذه
____________________
(١) فوك، يوهان - (المُستشرقون الألمان): ١٥.
(٢) سمايلو فيتش، أحمد - (فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر): ٤٩. وكذلك مقدّمة مصطفى محمود لكتاب سمايلو فيتش: ٣. وكذلك خدابخش، صلاح الدين في (حضارة الإسلام) الترجمة العربيّة: ٣٥.
المصادر على نحوٍ موضوعي نوعاً ما كانت تصطدم بحكمٍ سابقٍ يتمثّل في أنّ الدين المعادي للمسيحيّة لا يُمكن أنْ يكون فيه خير)(١) .
ج - ودعماً لهذا المخطّط فقد رافقت تلك الفترة استخدام أبشع وسائل الاضطهاد، وممارسة شتّى أنواع التنكيل بالمسلمين، وارتكاب أفضع جرائم القهر الديني والسياسي بحقّهم، ومحاربتهم نفسيّاً واقتصاديّاً، وصُودرت نتاجاتهم العلميّة والثقافيّة ونُسِبت إلى غيرهم من أعدائهم، وعملت الكنيسة على تأسيس محاكم التفتيش(٢) التي نكّلت بمَن تبقّى من المسلمين الأندلسيّين بعد سقوط الأندلس وغرناطة في أواخر القرن الخامس عشر، وأُعطيت صلاحيّات استثنائيّة واسعة أيّامفرديناند (٣) ،وإيزابيلا (٤) ،وفيليب الثاني (٥) ، وشمِل التقتيل والإحراق
____________________
(١) كراتشقوفسكي، إغناطيوس. (دراسات في تأريخ الأدب العربي) الترجمة العربيّة: ٧٥.
(٢) يُعزى تأسيس محاكم التفتيش إلى البابا(غريغور السابع) عام ١٣٣٣م، عندما أمر بتشكيل لجنة من كلّ قريةٍ أو بلدةٍ يرأسها قسّ، وبعضوية شخصيّتين بارزتين وذلك للتفتيش عن الهراطقة ومحاكمتهم (وقد أطلقت تسمية الهراطقة عند النصارى على أهل البدعة في الدين. والمقصود بهم هنا الذين ينتمون إلى الدين الإسلامي في بلاد النصارى). ثمّ ما لبث أنْ تسلّم المحاكم هذه جماعة الدومنيكان وغيرهم من الرهبان. وجماعة الدومنيكان أو ما يُطلق عليهم: الأُخوة الواعظون: هُم أعضاء الرهبانيّة التي أسّسها القدّيسعبد الأحد لدحض البِدَع عام ١٣٠٦م، وكانوا أرباب التعليم الفلسفي واللاهوتي في القرون الوسطى. دخلوا البلاد الشرقيّة في القرن السابع عشر، أسّسوا كليريكيّة الموصل عام ١٨٨٢م (وهي البيع التي يخدم فيها الشمامسة والقساوسة والأساقفة)، وكانت لهم فيها مطبعة عربيّة شهيرة، ولهم في القدس مدرسة الكتاب المقدّس.
راجع، براندتراند، جون في (تراث الإسلام) الترجمة العربيّة: ٧٠، وكذلك (القاموس (المنجد في الإعلام)).
(٣) فرديناند: ملك أراغون وهو المعروف بالكاثوليكي، ملك قشتالة (١٤٧٤ - ١٥٠٤م) بعد زواجه وإرثه عرش قشتالة من إيزابيل، أخذ غرناطة من العرب (المسلمين) عام ١٤٩٢م ووحد إسبانيا تحت سلطته ونظم إداراتها. وفي عهده اكتشف كريستوفر كولومبس أميركا. عن (القاموس (المنجد في الإعلام)).
(٤) إيزابيلا: (١٤٥١ - ١٥٠٤م) ملّقبة بالكاثوليكيّة وهي ملكة قشتالة التي تزوّجها فرديناند، فتوحّدت بهذا الزواج الدولة الأسبانيّة، وأدّى ذلك إلى سقوط غرناطة عام ١٤٩٢م. عن (القاموس (المنجد في الأعلام)).
(٥) فيليب الثاني: (١٥٢٧ - ١٥٩٨م) ابن كارل الخامس ملك أسبانيا وهولندا (١٥٥٦م). ثمّ ملك = البرتغال عام ١٥٨٠م، ويعتبر عهده أوج السيطرة الأسبانية في أوربّا. عن (القاموس (المنجد في الأعلام)).
والذبح جماعةً من المسلمين الذين تنصّروا ظاهراً، وأقاموا على عقيدتهم (الإسلاميّة) وظلّوا يمارسونها في الخفاء. وامتدّت صلاحيّات هذه المؤسّسة التنكيليّة لتنال من مصادر الفكر الإسلامي، وإحراق الكتب، وإتلاف كلّ ما يُؤدّي في نظر الأساقفة إلى إلحاق الضرر بالكنيسة.
وبالرغم من ذلك فقد (بقي المسلمون الذين ظلّوا في أسبانيا بعد استردادها (سقوط الأندلس) يحتفظون بكتبهم، باذلين غاية جهدهم لإخفائها عن أعيُن مكاتب التفتيش. ولمّا اضطرّوا إلى مغادرة وطنهم خبأوا كتبهم في فجوات الجدران، أو دفنوها تحت الأرض في بيوتهم المتروكة. وقد عثر في القرن الأخير مصادفة على عدّة مكتبات منها...)(١) . واستمرّت محاكم التفتيش قائمة في أسبانيا حتّى حلّها نابليون بونابرت عام ١٧٩٢م.
____________________
(١) كراتشقوفسكي، إغناطيوس (دراسات في تأريخ الأدب العربي) الترجمة العربيّة: ٧١ - ٧٢. ويذكر شكيب أرسلان في كتابه (الحلل السندسيّة في الأخبار والآثار الأندلسيّة) المجلد الأوّل: ٢٨٠ - ٣٨٣ الكثير من الأخبار عن صنوف الاضطهاد التي مُورست في حقّ مَن كانت محاكم التفتيش تشكّ بأنّه لا يزال على إسلامه من أهالي طليطلة، ومنها الإحراق بالنار ومصادرة الأملاك والتعزير.. إلخ. وذلك بتهم مثل عدم أكل لحم الخنزير، والامتناع عن شرب الخمرة وغيرها...
الاستعراب(١) أولاً ثمّ الاستشراق
نشأت ظاهرة الاستعراب نتيجة للاحتكاك المباشر الذي حصل بين بعض الطوائف المسيحيّة التي كانت تقطن إسبانيا وبين المسلمين العرب فاتحي الأندلس، والذي أدّى بدوره إلى تعميق عُرى التمازج العرقي والتعايش الاجتماعي والاتّصال الثقافي فيما بينهم. وقد أفرزت هذه الحالة ظهور طبقة اجتماعيّة واسعة من المجتمع الأندلسي اندمجت مع أوساط المسلمين، وتشبّهت بهم في سيرتهم وسلوكهم اليومي، وقلّدتهم في إقامة مناسباتهم وشعائرهم الدينيّة، وحتّى في دقائق وجزئيّات أُمورهم الحيويّة فأقدم الكثير منهم على الاختتان وفق مراسم المسلمين، وامتنعوا عن معاقرة الخمر وأكل لحم الخنزير، وغيرها من الممارسات التي كانت مألوفة في المجتمع النصراني. وقد أُطلق على هؤلاء (المُستعربين) الذين كان جُلّهم من أبناء الأندلس القُدماء الذين انحدروا من آباء إسبان، ومن خلال البحث والاستقصاء عن أحوالهم أمكن تصنيفهم إلى صنفين:
الأوّل: ويضم الذين دخلوا الإسلام أثناء الفتح (فتح الأندلس) وحسُن إسلام الكثير منهم، فأقبلوا على دراسة الفكر الإسلامي، وتدرجوا في شتّى العلوم. فكانوا أصحاب التآليف والتصانيف، وصارت لهم مكانة علميّة مرموقة تميّزوا بها
____________________
(١) مصطلح يطلق على الذين صاروا دُخلاء بين العرب، ثمّ سرى استعماله لأُولئك الذين دخلوا الإسلام بعد أنْ تعلموا اللغة العربيّة وتشبّهوا بالمسلمين العرب خاصّة في عاداتهم وتقاليدهم.
عمّن سواهم، وظهر فيهم العلماء والأُدباء والقادة العسكريّون، فحازوا إعجاب الحكام المسلمين وأصبح قسمٌ منهم ذوي نفوذ واسع في الحكم (ولكنّهم ظلّوا مع ذلك لا يجدون أنفسهم إلاّ مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة)(١) .
الثاني: كان يضم أُولئك الذين تشبّهوا بالمسلمين ظاهريّاً، ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، وكان تأثّرهم سطحيّاً على قاعدة التمثّل بالفاتحين والتشبه بهم. كما يرى ابن خلدون ذلك (المغلوب يتشبّه أبداً بالغالب). وبالرغم من إقبالهم على تعلّم اللغة العربيّة ودراسة آثار المسلمين وأفكارهم، وكذلك إعجابهم بالمنجزات الحضاريّة لهم، وانبهارهم بالطرح الثقافي الإسلامي الجديد. إلاّ أنّ هذا لم يكن ليصرفهم عن عدائهم الشديد للرسالة الدينيّة والإيديولوجيّة الإسلاميّة، ولا ليثنيهم عن رفضهم القومي للسلطة السياسيّة التي يخضعون لها.
ولا سيّما أنّ بعض الحكّام آنذاك كانوا لأغراض سياسيّة يستخدمون أساليب مِن شأنها أنْ تثير روح العصبيّة بين طَبَقات المجتمع الأندلسي، كأنْ يُقرّبوا طائفة على حساب طائفة أُخرى، ممّا يُؤدّي إلى نشوء العداء مع السلطة، وبالتالي محاولة الانتقام أو التقليل من شأن الرسالة والفكر الذي ينتمي إليه هؤلاء الحكّام.
فمثلاً عند اشتداد الروح العصبيّة بين القبائل العربيّة المتنافسة في عهد عبد الرحمان الداخل ويأسه من القضاء عليها وإزالتها، واتّخاذها أُسلوب المواجهة والمنافسة مع الحكم، لجأ إلى تكوين طبقة الأعوان والقادة، وربّاهم بنفسه واستعان بهم على إدارة دفّة الحكم، ونفوذهم ينمو نتيجةً لقربهم من الطبقة الحاكمة حتّى صاروا شركاء للخليفة في الحكم، ثمّ صاروا يدبّرون المؤامرات لإدارة الحكم بأنفسهم(٢) .
____________________
(١) د. إحسان، عبّاس (تأريخ الأدب الأندلسي): ٨٩.
(٢) مجلّة نور الإسلام. العددان ٢٧ - ٢٨ (العصبيّات وآثارها في سقوط الأندلس): ٣٤.
وعلى أثر ذلك تولّد الصراع بين العرب والمُستعربين، ولم يكن هذا الصراع سياسيّاً أو عسكريّاً فحسب، بل كان صراعاً يلتمس مبرّراته مِن أُطُر دينيّة، وينعكس على طبيعة التفكير الديني، الأمر الذي نشأ عنه نَمَطَان من التفكير: نمط يتَطرّف في تمجيد العرب دينيّاً، وآخر يتَطرّف في الاتّجاه المضاد.
وليس إلى الشكّ سبيل في أنّ ابتعاد الحكم العربي في الأندلس عن الإسلام، كان له الأثر الكبير في إعطاء الفرصة للمُستعربين كي ينتفضوا ويترجموا رفضهم بشكل حرب اتّخذت أبعاداً مختلفة، حتّى أنّ بعضاً منهم كان له الدور الكبير في إضرام فتنة طليطلة ضدّ قرطبة في بداية عهد الأمير محمّد بن عبد الرحمان التي تمخّضت عن المعارك التي خاضها ابن حفصون ضدّ الحكم العربي الإسلامي سنوات طوالاً بدأت من عام ٢٦٨هـ وانتهت بوفاته عام ٣٠٦هـ.
وصلت قوّة العداء بين الطرفين إلى الحدّ الذي دفع عمر بن حفصون، إلى الارتداد عن الإسلام والعودة إلى النصرانيّة، لكي يستميل النصارى إليه ويعينوه في قتاله ضدّ الحكم العربي، وذلك من خلال عمليّة أراد بها أنْ تكون انتقاماً من هذا الحكم.
وفي هذا الخضمّ المتلاطم مِن الفتن والصراعات والاضطرابات انتعشت الكنيسة، وبرزت الحوافز، وازدهرت الحركات الداعية إلى تقويض أركان الإمارة الأمويّة، واستُُنفرت القُوى المضادّة للإسلام، وارتفعت أصوات الغُلاة من النصارى برُدودِ فعلٍ متباينة، كان منها اندلاع حركة الاستشهاد كما أسلَفنا، وكذلك بُروز دعاوى مواجهة الوجود الإسلامي بأساليبٍ تتعدّى حدود المصادمات العسكريّة والمواجهات الدمويّة، تهدف إلى مقارعة المسلمين عن طريق الفهم العميق لإيديولوجيّتهم، ومعرفة أسباب قوّتهم ومنازلتهم بمناهجهم الفكريّة وقواعدهم الحضاريّة.
وكان للمُستعربين الدور الفعلي في الاختراق البشري والثقافي والسياسي للمجتمع الأندلسي، فوظّف فعلهم هذا بقصد أو بدون قصد، في بعض الأحيان، في خضمّ المشروع المعادي للوجود الإسلامي.
وإذا كان الاستشراق علماً يختصّ بلغات الشرق، وبالانجازات الحضاريّة المعبّر عنها بتلك اللغة، وبأديانهم وقيمهم وثقافتهم. وإذا كان قد فتح أمام الغرب والأوربّيين بصورةٍ عامّة أبواب الفكر الإسلامي، وآفاق نظامه الدقيق بهدف فهم الأُطروحة الإسلاميّة، التي غزت العالم وغيّرت الكثير من الثقافات السائدة والنظُم المنحرفة عن الفطرة الإنسانيّة، وتداعت أمامها أغلب النظريّات المتهرّئة، كان لابدّ من استطلاع دواعي هذه الأطروحة بل والمعايشة المباشرة والشاملة للوضع الجديد الذي طرأ على العالم، إزاء التحوّلات الخطيرة التي حصلت بفعل الإسلام والمسلمين.
وعليه فلابدّ للباحث المتتبّع للوقائع التاريخيّة من الاعتقاد بأنّ بِدء تكوّن الاستشراق، قد حدث بعد انتهاء عمليّات الفتح الإسلامي لشبه الجزيرة الأيبيريّة، أي بعد سنة ٧١٥م وبِدء استيطان العرب للمناطق المفتوحة، وأنّ ظاهرة الاستعراب الثقافي والاجتماعي والتشبّه بالفاتحين في عاداتهم وممارساتهم، لا يمكن فصلها عن تطوّر حركة الاستشراق وشروطها، والأوليّات الاجتماعيّة لتكوّنها.
بالإضافة إلى هذا فقد برز طرحٌ آخر كان له الدور الكبير في بلْوَرة الاستشراق، كان أبطاله وأدوات تنفيذه اليهود الذين وجدوا في المسلمين الفاتحين طريقاً للخلاص من الاضطهاد القوطي(١) ، وظلم الكاثوليكيّة. فتعاونوا معهم
____________________
(١) القوط: مجموعة شعوب منهم الشرقيّون ومنهم الغربيّون. والقوط الشرقيّون: استقرّوا أوّلاً في وادي الدانوب الشرقي، ثُمّ غزوا إيطاليا وأسّسوا فيها مملكة في أواخر القرن الخامس الميلادي. قضى عليها بوستينياس عام ٥٥٢م. والقوط الغربيّون: أقاموا غربي الدانوب في القرن الرابع الميلادي واعتنقوا = المسيحيّة الآريوسيّة (وهي بِدعة لدى النصارى، تنسب آريوس إلى الكاهن الاسكندري). احتلّوا روما عام ٤١٠م ثُمّ جلوا عنها ليستقرّوا في جنوب غربي فرنسا. ثمّ إسبانيا حيث أسّسوا مملكة ظلّت قائمة حتّى الفتح الإسلامي عام ٧١١م (القاموس (المنجد في الإعلام)).
وحالفوهم وتغلغلوا في قنواتهم الثقافيّة والاقتصاديّة، ولم يكن موقف اليهود هذا حبّاً للإسلام وحرصاً على المسلمين، وإنّما كان استراتيجيّة جديدة تؤهّلهم لتغيير مسار الأحداث لصالحهم، وهذا هو ديدنهم أينما وُجدوا، فبالرغم من القضاء المبكّر عليهم أيّام الدولة الإسلاميّة الأُولى على عهد الرسول (صلّى الله عليه وآله)، فإنّهم استطاعوا الظهور ثانيةً في أدوار مختلفة استهدفت هدْم الإسلام من داخله، حتّى أنّ بعضهم اعتنق الإسلام نفاقاً من أجل ذلك.
وعندما رأى اليهود أنّ موازين القُوى في الأندلس اختلّت لمصلحة المُستعربين ونصارى الشمال وحلفائهم الأوربّيّين، ومع بداية أُفول نجم الدولة الإسلاميّة ظهروا بصورتهم الحقيقيّة وكشروا عن أنيابهم، وبدت نواياهم السيّئة، فنقلوا ولاءهم إلى إسبانيا المسيحيّة، ونزحوا إلى المناطق الإسبانيّة المستردّة من سيطرة الدولة الإسلاميّة.
ملتحقين بمن سبقهم من إخوانهم الذين كانوا قد باشروا - بإغراء وتشجيع من أعيان الكنيسة - العمل في ترجمة التراث الثقافي الإسلامي، على نطاقٍ واسع خدمةً للمشروع الكاثوليكي الأوربّي، الذي نجح في مناغمة الهويّة العنصريّة الإسبانيّة بالمشاعر الدينيّة المتطرّفة لمقاومة أعداء المسيحيّة.
فكان اليهود أكفأ المُساهمين وأنشطهم لما ملكوا من (مشاركة في التراث العربي الإسلامي، استلهاماً واقتباساً ومحاكاةً ومنافسةً)(١) . إضافةً إلى إتقانهم للغاتٍ عدّة بحكم كثرة تنقّلهم، وتبدّل مواطنهم، وتوزّعهم الديمغرافي، ممّا أهّلهم للقيام بدورٍ أساسي، في حركة الترجمة والنقل عن العربيّة إلى العبريّة، وعنهما إلى اللاتينيّة.
____________________
(١) أسد، محمّد - (الإسلام على مفترق الطرق). الترجمة العربيّة: ١٥٦.
ولعلّه من غير المبالغة القول: إنّ اليهود هُم (المستشرقون) و(المُستعربون) التاريخيّون أينما حلّوا.
ومِن هذا يُمكن أنْ نفسّر تغلغل الإسرائيليّات ودخولها ضمن تراثنا الفكري الإسلامي، وأثرها في تفسير القرآن، وما خلّفته من موروثات ثقافيّة دينيّة محرّفة، ساهمت في إبعاد المسلمين عن الفهم الصحيح للقرآن والسنّة النبويّة، وبهذا كان لهم الدور المؤثّر في انحراف المجتمع الإسلامي في الأندلس عن مساره، وذلك من خلال ما ابتدعوه من فِرَقٍ هدّامة تنتهي بجذورها إلى لونٍ مِن ألوان العمل الثقافي اليهودي.
إنّ الانتماءات القوميّة المختلفة التي كانت قد شكّلت الهيكل العام للمجتمع الإسلامي في الأندلس، لم تكن سدّاً أمام حصول التداخل الاجتماعي والالتقاط الثقافي بين تلك القوميّات، وهذا التداخل والالتقاط أفرز حالةً جديدةً مِن أبرز سِماتها تبلور أفكار وعقائد وإيديولوجيّات مختلفة.
وعلى هذا فقد أصبحت الأندلس ولأوّل مرّة في التأريخ حالةً حضاريّةً فريدةً من نوعها بين الشرق والغرب، حيث إنّ التناقضات الدينيّة والفكريّة والسياسيّة جعلتها أرضاً خصبةً، لولادة ثقافة أوربيّة حديثة كانت نواتها الطرح الإسلامي الجديد الوافد من الشرق، لكنّها رفضته ديناً وعقيدة لها من خلال رفضها لمظهره المتمثّل بالمسلمين، إلاّ أنّها عملت على تمثّل ثقافتهم وعلومهم للالتفات عليهم، والسعي إلى إحباط الجهود الحضاريّة والفكريّة والعلميّة لهم.
في هذا المناخ المركّب الذي تحالفت فيه قُوى وإمكانات الكنيسة الكاثوليكية والإسبان المهاجرين من الأندلس الإسلاميّة والمُستعربين، بتسهيل من الجهود الثقافيّة لليهود لاحقاً، وعلى أساس مشروع استرداد إسبانيا للنصرانيّة الأوربيّة نمت (قابليّة الوجود) الاستشراقي بِدءاً بالأندلس، ثمّ تطوّرت بلبوس متنوّع، إلاّ أنّ هذه القابليّة اقتصرت في أوّليّاتها على الاتّصال والتعرّف
والاطلاع والتعايش الفاعل مع الفاتحين. وبشكل إقبالٍ مشوبٍ بالحذر على تعلّم اللغة العربيّة وعلومها.
وعليه فمن المُستبعد تصديق زعم البعض من أنّ (الاستشراق قد نشأ حقّاً في منتصف القرن الثامن الميلادي في الأندلس)(١) ، إذ إنّ المسلمين الذي لم يكن قد مضى على دخولهم (أيبيريا) أكثر من أربعين سنة، وهُم في غالبيّتهم من العسكر البربري، لم يكونوا بعد متهيّئين لعرض أفكارهم وثقافتهم المدوّنة على أهل البلاد المفتوحة؛ لأنّ دَورهم قد اتّخذ منحىً عسكريّاً في المرحلة الأُولى من استقرارهم في الأندلس.
أمّا دورهم كروّاد ثقافة وحَمَلة فكر، فأغلب الظن أنّه تأخّر عن منتصف القرن الثامن نصف قرن على الأقل؛ لأنّ المرحلة تستدعي بالضرورة مدىً زمنيّاً كافياً ليتسنّى لهم إتمام عمليّة الاستيطان والاستقرار في عالمهم الجديد، قبل طرح أنفسهم على أنّهم دعاةُ ثقافةٍ وفكرٍ وحضارة.
وعليه فلا يُمكننا الحديث عن حالةٍ ثقافيّةٍ مزدهرة وحقيقيّة في الأندلس إلاّ مع (بداية (الإسلاميّة) في المشرق والمعاصرة للعباسيّين)(٢) في عهد الحكم الأوّل (٧٩٦ - ٨٢٢م)، حفيد عبد الرحمان الداخل، وعهد عبد الرحمان الداخل، وعهد عبد الرحمان الأوسط (٨٢٢ - ٨٥٢م) ابن الحكم الأوّل، فليس من المُمكن - منطقيّاً - أنْ تنتقل إلى المُستعربين وغيرهم من العناصر المكوّنة للمجتمع الأندلسي حالةٌ ثقافيّةٌ لم تكن متيّسرة أصلاً للعرب والمسلمين الأندلسيّين الآخرين أنفسهم. وهُم لا يزالون منهمكين في تأسيس دولتهم وتحصينها والتأقلم مع خصوصيّات الوطن الجديد.
ففي تلك الفترة التي أشرنا إليها بدأ البحث التأريخي يكتشف وجود
____________________
(١) سمايلوفتش، أحمد - (فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر): ٦٧.
(٢) فيرينيه، جوان - (تراث الإسلام) القسم الثالث، الترجمة العربيّة: ١٦٩.
مُدَوّنات إسبانيّة محمّلة بتأثيرات عربيّة واضحة في مضمونها، ممّا يثبت أنّ مؤلّفيها قد أخذوا مادّتهم التاريخيّة من مصادر عربيّة. ومن تلك المدوّنات( مخطوطات مختلفة وُجِدت في (أُوبيط) وهي محفوظة في مكتبة الاسكوريال، وقد احتفظ بها القدّيس (أولوجيوس) القرطبي (توفّي سنة ٨٥٩م) ونُقِلت إلى (أوبيط) عام ٨٨٤م)(١) .
إنّ حركة الترجمة من العربيّة إلى اللاتينيّة وغيرها مِن الأنشطة الثقافيّة والعلميّة، كالاقتباس والنقل والاستنباط والاستيحاء من قِبل المُستعربين والأوربّيّين، وإنْ كانت لأغراض عقائديّة كما أشرنا، إلاّ أنّها لم تتحوّل إلى حالة ثقافيّة شاملة إلاّ في القرن التاسع الميلادي، بعد أنْ خَبَر النصارى الإسبان عُمق الثقافة الإسلاميّة وتعرّفوا عليها، أي بعد مرور مِئة سنة ونيف على انتهاء عمليّات الفتح الإسلامي للأندلس.
وبعد اكتمال شروط التفاعل والتمازج بين شرائح المجتمع الأندلسي المختلفة، وبالتالي بروز مشروعَين متقابلين كانا يمثّلان طرفَي الصراع: أحدهما يؤكّد على استعادة مجد المسيحيّة بكلّ توجّهاته، الإيديولوجيّة والسياسيّة والثقافيّة والعسكريّة، والانتقام من المسلمين، والعمل على عودة إسبانيا إلى الحضيرة الأوربيّة المسيحيّة.
والآخر كان يؤكّد على إشاعة روح التغيير في البلاد، والتشبّث لتعميق الروح الإسلاميّة مستفيداً من عظيم تراثه، ومتانة فكره وثقافته، وأصالة حضارته القائمة على العدل والتوازن.
هكذا نشأ الاستشراق وانتقل مروراً بالاستعراب من طور القابليّة، إلى طور التحقّق الفعلي كحالة ثقافيّة ليبدأ بالتكرّس والتحوّل إلى مؤسّسة وصرحٍ وفق خططٍ وأهدافٍ إستراتيجيّة. وابتدأ من القرن العاشر الميلادي يوم غدت
____________________
(١) المصدر السابق: ١٦٩.
الأندلس مركزاً لانتقال الازدهار الحضاري الإسلامي والإنساني على قلب أوربّا، فكانت إسبانيا والإسبانيّون الأكثر انفعالاً وتأثّراً بالحضارة الإسلاميّة؛ لأنّ الإسلام عاش بين ظهرانيهم ثمانية قرون، وانتشر منهم إلى بقيّة المناطق الأوربيّة شمال أيبيريا. وبالرغم من أنّ أغلب النظريّات الاستشراقيّة العامّة وتطوّراتها التاريخيّة قد وقعت خارج إسبانيا، إلاّ أنّ أغلب أُطروحات الأوربّيين ومعلوماتهم وأخبارهم عن الإسلام والمسلمين، كانت محاكاةً للظروف والتناقضات السياسيّة والاجتماعيّة والعقائديّة، التي عاشها المسلمون في الأندلس، وموسومة بالصبغة الأندلسيّة من حيث النشأة والتوجّه والحركة.
بروز نظريّات الاستشراق الاستعماري
إنّ تجربة الأندلس وما تمخّضت عنه من أحداث وتغيّرات تركت آثارها على المجتمع الأوربّي، قد أفرزت إحساساً لدى الأوربيّين بالخطر الداهم الذي ينتظرهم، ومِن ورائه الضعف والخواء الذي يكتنف ثقافتهم وأُصولهم الفكريّة، وبالتالي انهيار بنائهم الحضاري المُتهافت، ممّا دعاهم - بردودِ فعلٍ شديدة - للتصدّي بمختلف الوسائل وبشكلٍ مدروس ومنظم للحيلولة دون اتّساع دائرة التأثر بإشعاعات المدّ الإسلامي الذي غمر إسبانيا. وقد شجّعهم على ذلك دافع ذو بعدٍ ديني وهو أنّهم (مسيحيّون ياهدون ضدّ أعداء المسيحيّة)(١) .
وعلى هذا كان الاستشراق أحد ردود الفعل، ولعلّه الأبرز في معادلة الصراع الحضاري بأشكاله الدينيّة والسياسيّة والفكريّة، ولا سيّما أنّ الغرب والأوربيّين بشكلٍ خاص ينظرون آنذاك، إلى كون المشرق الإسلامي (ملكاً للإمبراطوريّة الرومانيّة)(٢) يجب استرداده من أيدي المسلمين، وإرجاعه إلى حضيرة الإمبراطوريّة الرومانيّة المتهرّئة.
فانعكس هذا التفكير على متبنّياتهم الإستراتيجيّة للمواجهة كإحدى الثوابت التي يؤمنون بها، ويعملون لتحقيقها. وقد وظّف الاستشراق في هذا السبيل لخدمة نوايا استرداد العالم الإسلامي الذي
____________________
(١) وات، مونتغمري - (فضل الإسلام على الحضارة الأوربيّة) الترجمة العربيّة: ٦٨.
(٢) الجندي، أنور - (الإسلام وحركة التأريخ): ٣٨٠.
سيتّخذ فيما بعد أُطُراً وأشكالاً حديثة تنسجم وطبيعة مراحل الصراع، وليس من المستبعد أنْ تكون حركة الكشوف الجغرافيّة حول شواطئ العالم الإسلامي، قد جاءت بهدف السيطرة على المنطقة خدمةً للمصالح الأوربيّة الاستعماريّة، ووفق هذه الرؤية يُمكن تفسير أعمال (هنري الملاح) أو (ماركوبولو) أو (كريستوفر كولومبس)، على أنّها حلقة من حَلَقَات المؤامرة التي حُبِكت لاستعمار المشرق الإسلامي.
وممّا يؤكّد ظهور هذا التوجّه بشكلٍ واضح، ما حصل (في أواسط القرن الثامن عشر عندما أخذت أوربّا تتحفّز لاستعمار الشرق، وأخذ علماؤها يبحثون في تأليف جمعيّات لهذهِ الغاية فأُنشئت منذ ذلك العهد في أوربّا وأميركا عدّة جمعيّات للمستشرقين، وأقدمها عهداً الجمعيّة الآسيويّة في باريس التي أُسّست سنة ١٨٢٢م بمعرفة شيخ المُستشرقين من الفرنسيّين (سلفستر دي ساس)، ثمّ أُنشئت معاهد للّغات الشرقيّة في جميع الدول، تابعة لوزارة المستعمرات أو لوزارة الخارجيّة المشرفة على الشؤون السياسيّة)(١) .
إلاّ أنّ الكثير مِن المحاولات لم تحقّق غاياتها الأساسيّة (فقد أوقفتها القوّة الإسلامية العثمانيّة النامية، واستطاعت أنْ تقضي عليها)(٢) ، ولكنّ هذا القضاء كان مؤقّتا، حيثُ استأنفت من جديد مع مطلع القرن التاسع عشر الخطط الاستعماريّة الخبيثة لتحقيق ما عجزت عن تحقيقه قبل قرون، أي منذ استرداد إسبانيا من أيدي المسلمين، وقد نجحت نجاحاً كبيراً في إقامة صرح الاستشراق، وتطوير حركته بما يخدم سعيها نحو بسط سلطتها على عموم الشرق والشرق الإسلامي منه خاصّة.
____________________
(١) عبد الوهاب حمودة، من زلاّت المستشرقين، مجلّة رسالة الإسلام: ٣٣، السنة التاسعة.
(٢) الجندي، أنور - (الإسلام وحركة التأريخ): ٣٨١.
الفصل الثّاني
المراحل والأدوار التي مرّت بها الحركة الاستشراقيَّةُ
* المرحلة الأولى: مرحلة الانفتاح لاحتواء الحضارة الإسلاميّة.
* المرحلة الثّانية: مرحلة الفرز لاستلاب الحضارة الإسلاميّة.
* المرحلة الثّالثة: مرحلة تغريب إفرازات الحضارة الإسلاميّة المستلبة.
* المرحلة الرّابعة: مرحلة استعمار الشّرق وتطبيعه على الحضارة المغرّبة.
رغم أنّ مسيرة الاستشراق كحركة قد تشعبت وتطورت في مناهجها وأساليبها إلاّ أنّ دوافع التعصّب الديني والشعور بالتفوّق العرقي ظلّ هو الخيط الأحمر الذي حيكت به أبعاده الأساسيّة.
وحتّى يُمكننا الإحاطة الشاملة بخارطة هذه الأبعاد، وطبيعة الآثار والنتائج التي حقّقتها لابدّ لنا من تقسيم حركة الاستشراق إلى عدّة مراحل وادوار رئيسيّة هي:
المرحلة الأُولى
مرحلة الانفتاح لاحتواء الحضارة الإسلاميّة
ويؤرّخ لهذهِ المرحلة منذ بدايات الفتح الإسلامي لإسبانيا وتأسيس دولة الأندلس، وبحكم التعايش الذي حصل بين القوميّات المختلفة، التي كانت تحمل بصمات أفكارها، برّز الفكر الإسلامي والحضارة الإسلاميّة قوّةً مؤثّرةً وجديدةً في حياة الأندلسيّين، خصوصاً وأنّ الإسلام قد دخل عليهم بشكل مفاجئ.
من هنا بدأت مقدّمات الاستشراق وذلك بانفتاح الإسبانيّين والمُستعربين على المسلمين والفكر الإسلامي، وبشكل مُدبّر ومدروس وذو أهدافٍ ومرامٍ بعيدة المدى، وهذا
ما استقرأناه من كتب التاريخ التي تؤرّخ لتلك المرحلة(١) ، حيثُ تمّ في ذلك الوقت ترجمة أمّهات الكتب الإسلاميّة من العربيّة إلى الإسبانيّة والعبريّة واللاتينيّة، وانصبّ الجهد على هذه المترجمات لدراستها واستيعابها. وبحكم وجود اليهود وصراعهم المستمر مع المسلمين منذ العهد المدني لرسول الله (صلّى الله عليه وآله)، كان لهم القسط الأوفر في هذا الاتّجاه في سبيل خدمة مصالحهم وطمس هويّة العلوم الإسلاميّة، عن طريق نسبتها لهم وأنّها ليست من الحضارة الإسلاميّة والفكر الإسلامي في شيء، ومن هنا وضعت المخطّطات لترجمة القرآن الكريم ترجمةً اتّخذت من الإسرائيليّات والأساطير الملفّقة إطاراً مرجعيّاً لها، وامتدّت هذهِ المخطّطات لتشمل ترجمة كتب الحديث والتفسير، وكذلك دراسة اللغة العربيّة ووضع المعاجم لها.
وبهذا فقد أخذت أوربّا الظمأى تعبُّ من منهل الشرق الإسلامي، ولا ترتوي على مدى عشرة قرونٍ متعاقبة، ابتدأت من عام ٧١١م تاريخ فتح الأندلس إلى نهاية القرن السابع عشر، وما العصر الذي سمّته أوربّا عصر النهضة أو (عصر الإيديولوجيّة العقلانيّة العلمانيّة)(٢) ، إلاّ عصر امتلاء وتضخّم بطن أوربّا بعطاءات الإسلام الحضاريّة، التي تحوّلت فيما بعد إلى (نقطة حراسة أماميّة للغرب)(٣) .
ويمكن القول: إنّ بعض الباحثين قد أخطأوا في تحديد هذه المرحلة، حينما اعتقدوا بأنّ أوّل اتّصالٍ جادٍ وفاعل بين الثقافة الإسلاميّة والتلقّي الأوربّي قد حدث نتيجة للحروب الصليبيّة، التي (عيّنت (في رأيهم) في المقام الأوّل والمقام
____________________
(١) أشرنا إلى ذلك في فصل (الجذور التاريخيّة لحركة الاستشراق).
(٢) الدكتور سلمان، سمير (الجذور التكوينيّة للاستشراق في الأندلس) عن مجلّة التوحيد العدد ٣١، ص١١٣.
(٣) غابريلي، فرانشكو في (تراث الإسلام) القسم الأوّل تصنيف شاخت وبوزورت الترجمة العربيّة ص١١٠.
الأهم موقف أوربّا من الإسلام لبضعة قرون تتلو)(١) ، واتّفقت مع بزوغ فجر المدنيّة الأوربيّة(٢) ، وقيام (عصر النهضة ذي الروح الجديدة والوعي الجديد بالعالم)(٣) .
في مقابل هذا كان المسلمون الأندلسيّون، باعتبارهم حَمَلة رسالة تدعو إلى التسامح والتقارب والتثاقف، والانفتاح الفكري والعلمي وحريّة الفكر، قد فتحوا خزائن معارفهم وعلومهم لكلّ طالبِ ثقافةٍ وعلم مهما يكن معتقده الديني وانتماؤه العرقي(٤) ، فغصّت الجامعات الإسلامية في طليطلة وقرطبة، مدينة الثلاثة آلاف والثمانمِئة والثلاثة والسبعين مسجداً(٥) ، بما يعنيه المسجد باعتباره مؤسّسة متعدّدة الاهتمامات والخدمات، وبطلاّب العلم الأوربيّين (فتلقّوا العلم مجّاناً مع تقديم الطعام والمسكن أحياناً، وهذا مثال يحمل في طيّاته أعظم مبادئ الرقيّ والتسامح والتمدّن. كما أنّ الجامعات الأوربيّة إنّما نشأت تقليداً للجامعات العربيّة في إسبانيا)(٦) .
____________________
(١) أسد، محمّد (الإسلام على مفترق طُرق) الترجمة العربيّة ص٥٥.
(٢) المصدر نفسه - ص٥٤.
(٣) إتنغهاور، ريتشارد في (تراث الإسلام) تصنيف شاخت وبوزورث - الترجمة العربيّة - ص١٣١.
(٤) بلغ شغف المُستعربين بالثقافة العربيّة الإسلاميّة حدّاً جعلهم ينسون لغتهم الأُم. فاضطرّ العرب إلى أنْ يُترجموا الإنجيل إلى اللغة العربيّة، ليتسنّى لنصارى الأندلس المُستعربين قراءته باللغة التي استهوتهم. راجع كراتشقوفسكي، اغناطيوس (دراسات في تاريخ الأدب العربي) الترجمة العربيّة. ص٥٩.
(٥) جرجي زيدان، (تاريخ التمدّن الإسلامي) م٢ ص٦٢١.
(٦) مظهر، جلال (أثر العرب في الحضارة الأوربيّة) ص١٥٨. راجع أيضاً الطويل، توفيق (في تراثنا العربي والإسلامي) ص٢١٢ - ٢١٣.
المرحلة الثانية
مرحلة الفرز لاستلاب الحضارة الإسلاميّة
وبها يتمّ الانتقاء المدروس للعلوم والنظريّات الفكريّة، لغرض تمثّل ما يخدم النهضة الأوربيّة، وبناء ركائزها وتمهيداً لاستعمار الشرق فيما بعد. ويؤرّخ لهذهِ المرحلة بالنصف الأخير من القرن الثالث عشر الميلادي وذلك عندما استطاع، بعد عدّة إخفاقات، إقناع المجمع الكنسي العام في فيينّا عام ١٣١١م بإصدار القانون العام رقم (١١)، والذي يقضي بتدريس اللغات الشرقيّة في خمس جامعات أوربيّة، وقد صدر هذا القانون مع تحديد مدرّسين كاثوليكيّين لكلّ جامعة، ليقوما بتدريس هذه اللغات وعلى رأسها اللغة العربيّة(١) .
وفي هذهِ المرحلة بذل كبار رجال الاستشراق جهدهم من أجل استثمار الحضارة الإسلاميّة والفكر الإنساني الإسلامي، في بناء الفكر والحضارة الأوربيّة والغربيّة، وقد استخدموا الكثير من الأساليب لخدمة هذا الغرض، منها ردّ الفكر الإنساني عموماً إلى الفكر اليوناني، دون الرجوع إلى الفكر الإسلامي.
ولعلّ جذور هذهِ المرحلة يعود إلى إدراك الأوربيّين لضرورة فهم الحضارة الإسلاميّة، ودراستها للوقوف في وجهها وصدّها عن الامتداد، ولا سيّما أنّهم أحسّوا بخطر تأثير المبادئ والأفكار الحضاريّة التي أتى بها الدين الإسلامي، وأثرها على المجتمع الأوربّي آنذاك، وقد تجلّى ذلك في أقوال بعض المُستشرقين منهم(فرانز
____________________
(١) عن مجلّة رسالة الجهاد - العدد ٧٢ - السنة السابعة - ١٩٨٨م ص٢٦، عن ندوة الدين والتدافع الحضاري في محور البحث الثالث (الاستشراق كأداة مواجهة للإسلام).
دوزنتال) حين يقول: (إنّ الهدف هو الوصول إلى فهم عميق للتفكير الديني الكلامي عند المسلمين، أملاً أنْ يصبح الأوربيّون أقدر على التعرّف على هذا التفكير، واستغلال ما كانوا يتصوّرون أنّه مَواطن الضعف فيه)(١) .
ولعلّ الإيديولوجيّة الاستعماريّة تمتد بجذورها إلى تلك المرحلة، حيثُ مُورست أبشع وسائل المصادرة والاستغنام العلميّين عن طريق فرز النظريّات الإنسانية والعلميّة التي جاء بها المسلمون، وانتحال ما يرَونه مناسباً منها، ومحاولة إبرازها على أنّها من أُمّهات الفكر الأوربّي ومن نتاجاتهم العلميّة، وكما يقول الباحث الكاتب(د. ياسين عريبي) : (إنّ بهذه المرحلة دخلت أوربّا عصر النهضة، وخرجت من العصر الوسيط المتخلّف حيث تمّ فيما بعد تعميم الدراسات الشرقيّة والإسلاميّة والتحكّم في علومها بتوظيفها في بناء الحضارة الأوربيّة)(٢) .
المرحلة الثالثة
مرحلة تغريب إفرازات الحضارة الإسلاميّة المُستلبة
في هذهِ المرحلة - التي يُمكننا أنْ نسمّيها بعصر النهضة الحقيقيّة لأوربّا - ازدهرت تجربة الاستشراق وتطوّرت وانتقلت إلى محاولة تغريب الثقافة الإسلاميّة والعربيّة، والثقافات الإنسانيّة المقرّبة والمؤسلمة، لاستثمارها من قِبَل الغرب ليُعمِّر بها أُسُس نهضته ويُشيّد مَدنيّته التي يصبو إليها، وفيها سُرِق النموذج
____________________
(١) فوك، يوهان في (المستشرقون الألمان) ص١٥.
(٢) عن مجلّة رسالة الجهاد - العدد ٧٢ - السنة السابعة ١٩٨٨ ص٢٦ عن ندوة الدين والتدافع الحضاري في محور البحث الثالث (الاستشراق كأداة مواجهة للإسلام).
الثقافي والحضاري الإسلامي في الحريّة الفكريّة، والأخلاقيّة العلميّة والبحث النزيه والتسامح الديني، استناداً إلى منهج توحيدي إنساني، ومقارنةً بسيطةً بين الحالة الثقافيّة والحضاريّة المتخلّفة لأوربّا قبل هذهِ المرحلة، وحالتها اللاحقة تكشف عن مدى التغيير الهائل كمّيّاً وكيفيّاً في هذا الاتّجاه.
ولعلّ الإرهاصات الأوليّة لهذا التغريب بدأت في العصور الوسطى على يد البابا(سلفستر الثاني) والقدّيس(أنسلم) وغيرهما.
ومن أبرز نماذج هذا التغريب ما امتدّ إلى الفكر الفلسفي، وإلى النظريّات الكلاميّة ما ظهر على يد (ديكارت)(١) حيث حاول استيعابالنظريّة السينوية في شموليّتها، محاولاً التعتيم عليها من خلال التركيب مع المذاهب الكلاميّة دون أنْ يذكر مفكّراً إسلاميّاً على الإطلاق، ومنها قياملايبنيتز (٢) من بعده بعمليّة تركيبٍ أوسَع وأشمل ليكمل ما أهمله (ديكارت)، وهكذا من بعده أمثال: مالبرانش، وفولف، وكروزيوس...
وقد اعترف (لايبنيتز) باغترافه من معين المعرفة في الفكر الإسلامي، خاصّة علم الكلام، فإنّه أي (لايبنيتز) يصف هذا العلم بأنّه وجده كذَهبٍ مكنوز
____________________
(١) ديكارت، رينيه (١٥٩٦ - ١٦٥٠م): فيلسوف وفيزيائي ورياضي فرنسي. يُعتبر في رأي كثير من الباحثين أبا الفلسفة الحديثة ومؤسّسها، اشتهر بكتابه (مقالة في المنهج) عام ١٦٣٧م، وفيه أطرح كلّ المعتقدات السابقة ليُعاود البحث عن الحقيقة، شاكّاً في كلّ شيء إلاّ حقيقة واحدة وهي أنّه يشك، ومن هنا كلمته المشهورة: (أنا أشك فإذن أنا أفكّر. وأنا أُفكّر فإذن أنا موجود). عن موسوعة المورد المجلّد ٣، ص١٨٠.
(٢) لايبنيتز غوتفريد فيلهلم (١٦٤٦ - ١٧١٦م): رياضيّ وفيلسوف ومخترع ألماني. ولد في (لايبسيك) حاول معبوسيه دمج الكنيستين الكاثوليكيّة والبروتستانتيّة. اكتشف أُسس (التحليل الحسابي)، من أتباع الفلسفة المثاليّة وقال: إنّه لا تعارض بين الإيمان والعقل. ابتكر عام ١٦٧١م أوّل آلة حاسبة تقوم بعمليّات الجمع والضرب.
عن المنجد - في الإعلام - ص٦١٠ وكذلك موسوعة المَورِد المجلّد ٦ ص١٠٤.
في التراب المتبربر،(١) بل إنّه لا يكتفي بوصف المسلمين بالمتوحّشين، بل يخطّط في كتب ثلاثة لاستعمار مصر ويحرّض على ذلك، وبرغم اعترافه بأنّ النبيّ محمّد (صلّى الله عليه وآله) قد بشّر بالدين الطبيعي، فإنّه حاول النيل من الإسلام في الكثير من كتاباته.
ولا يفوتنا أنْ نسجل تحفّظنا العلمي من محاولة التغريب هذه، حيث إنّنا نرفض أنْ يكون مضمون هذا التغريب بصورته الفعليّة، هو في أصله منسوب على الحضارة والفكر الإسلامي، وذلك لِما أُحدِث فيه من تركيبٍ وخلطٍ و تغيير أفقده الكثير من حقيقته وصورته الأصليّة، ولأنّ الهدف الحقيقي مِن وراء هذا التغريب ليس هو فرز ونقل النموذج الحضاري وعلوم المسلمين إلى أوربّا فحسب، بل هو في شقّه الثاني مَحْقٌ لهويّة وعوامل القوّة والأصالة في الفكر الإسلامي ومنهجه في الحياة، ويمكننا استثناء ما يتعلّق منها بالعلوم الطبيعية (كالطب والفيزياء والكيمياء والفلك وأمثالها)، فهي غالباً ما تكون في أصولها لدى المسلمين سُرقت ونُسِبت إلى أوربّا واستثمرت مدنيّا.
المرحلة الرابعة
مرحلة استعمار الشرق وتطبيعه على الحضارة المغرّبة
في هذهِ المرحلة التي غالباً ما كانت متداخلة ومصاحبة لمراحل الاستشراق وتطوّره، عمل الاستشراق على التعاون والامتزاج مع الحركة الاستعماريّة للبلدان الإسلاميّة، وبالذات في النصف الأخير من القرن التاسع عشر والنصف
____________________
(١) نسبة إلى البرابرة، وهو اسم أطلقه اليونان ثمّ الرومان على الأجانب من الأُمم من غير اليونانيّين والرومانيّين.
الأوّل من القرن العشرين، حيثُ تمكّن الاستعمار من تطبيع الثقافة المغرّبة وضخِّها إلى البلدان التي يُريد استعمارها، وتعميمها في كافّة مرافق الحياة بحيث تكون هذه الثقافة المغرّبة متزامنة مع نموّ المدّ الاستعماري لهذهِ البلدان، كذلك عند استقرائنا للتاريخ الحديث الذي يؤرّخ للاستعمار العسكري للبلدان الإسلاميّة، نرى أنّ كثيراً من المستشرقين كان لهم الدور الكبير في مساعدة الدول الأوربيّة المستعمرة، حتّى إنّ قسماً منهم قد عمِل في نفس وزارة المستعمرات لتلك البلدان كما أسلفنا سابقاً، وعندما كان الشرقيّون وخاصّة المسلمين منهم في تلك الفترة يشكون العزلة الفكريّة والحصار الحضاري، والافتقار إلى أبسط وسائل التعليم والانتشار الثقافي التي فرضتها حالة السلطات المتحكّمة فيهم، بعد أنْ كانوا متربّعين كأساتذة وأساطين على عرش العلم والحضارة الإنسانيّة في أنحاء المعمورة.
أخذ الأوربّي المستعمر يجهز جيشه المسلح من جهة وعلماءه ومثقفيّه من جهة أُخرى لكي يغزو العالم الإسلامي عسكريّاً وفكريّاً، وحتّى عندما انتهى عهد الاستعمار العسكري - شكلياً - بقي أثره واضحاً في استمرار الحركة الاستعماريّة الفكريّة والمنهجيّة التي غزت العالم الإسلامي متمثّلة بالنظريّات الماديّة والاتجاهات القوميّة التي صِيغت بأشكالٍ برّاقة وجذّابة اتخذت طابعاً تحرّرياً وسياسيّاً يُناغي العواطف الساذجة للمسلمين. بهذا نرى أنّ تطبيع بلاد المسلمين على التغريب كان لهُ دورٌ كبير في تأكيد التسلّط الاستعماري على الشرق، ولعلّ آثاره ونتائجه ومصاديقه واضحة وجليّة إلى يومنا هذا.
الفصل الثّالث
المدارسُ الاستشراقيّة
* خلفيّات المستشرقين
* المدارس الاستشراقيّة.
* النّموذج: المدرسة الاستشراقيّة الفرنسيّة.
* المميّزات الأساسيّة للمدرسة الاستشراقيّة الفرنسيّة.
* نشأة المدرسة الاستشراقيّة الفرنسيّة وعوامل نموّها وتطوّرها.
* مناطق نفوذ المدرسة الاستشراقيّة الفرنسيّة.
* صِيَغ وأساليب المدرسة الاستشراقيّة الفرنسيّة وتشكيلاتها.
* أثر المدرسة الاستشراقيّة الفرنسيّة على الفكر الاستشراقي العام.
خلفيّات المستشرقين
لقد أصبح من الواضح لدينا أنّ حقيقة الاستشراق والتعريف الدقيق له هو: أنّه حركة ذات جذور ودوافع أوسع وأعمق من المدّعى المُعلن له، من أنّه: عملٌ علميُّ محض يُعنى باللغات والآداب والعلوم الشرقيّة، أو أنّه اتّجاه علمي لدراسة الشرق الإسلامي وحضارته. بل إنّ هذا الادّعاء لا يعدو كونه ظاهراً يُخفي تحته أهدافاً غير معلنة هي الواقع الحقيقي من ورائه.
وقد تجلّت هذه الأهداف شيئاً فشيئاً في القرنين الأخيرين حتّى بان - بشكلٍ لا يدَع مجالاً للشك والتردّد - أنّ الاستشراق قد استوعب في حركته أغلب التطلّعات الحضاريّة لأوربّا، ومهّد لحركتها الاستعماريّة في الشرق.
وتأكّد هذا المعنى عند استعراضنا لنشأة الاستشراق وتبلوره ضمن مسير حركته الأولى، وسيتأكّد لنا أكثر عند تقييمنا للجهد الاستشراقي المطروح ضمن مراحل تكوّنه وصيرورته إلى عصرنا الحاضر. وتمهيداً لذلك نعرض عدّة خلفيّات في واقع المستشرقين، استُلّت من خلال ما سبق، لنسلّط من خلالها الضوء على منهجيّة التقويم والمراحل التي مرّ بها:
الخلفيّة الأُولى:
بلحاظ نشأة الاستشراق واقترانه بالتبشير بصبغته الاستعدائيّة التي بدأ به
بهدف اختراق المسلمين ثقافيّاً، لدحرهم باستلاب مواطن قوّتهم وإخمادها في واقعهم، نجد أنّ أوائل المستشرقين كانوا مبشّرين نصارى، وكان طابع احتقار الإسلام والمسلمين السمة البارزة في اتّجاهاتهم الفكريّة والثقافيّة، ممّا انعكس بشكلٍ كبير على ما استهدفوا دراسته من الإسلام وواقع المسلمين، فجاءت تلك الدراسات والأبحاث مشوّهةً ناقصةً مليئةً بالمثالب والافتراءات التي لا تستند إلى دليل، فهم لا يرون لغير مذهبهم فضلاً وحقّاً في الوجود.
يقولهنري جيسب المستشرق والمبشّر الأميركي: (المسلمون لا يفهمون الأديان ولا يقدّرونها قدرها... إنّهم لصوص، وقَتَلة، ومتأخّرون، وإنّ التبشير سيعمل على تمدينهم)(١) . إنّ هذا المعنى الذي أشرنا إليه يُعتَبر جزءاً أساسيّاً من التفكير الأوربّي، وغريزةً موروثةً، وانطباعاً راسخاً فيهم مُنذ سقوط الأندلس.
وقد اتّخذت المواجهة للإسلام شكلاً جديداً بعد الحروب الصليبيّة، حيثُ انتهجت أُسلوب الغزو الفكري المبرمج للمسلمين بهدف فصلهم عن الأُسُس والمضامين الحيّة لدينهم، والتي يَكمن فيها سرّ قوّتهم، ممّا خلّف تأثيراتٍ بالغةً في عقول الأوربيّين استثمرتها المؤسّسات السياسيّة، ووظّفتها في عمليّة خلق الأرضيّة الفكريّة والثقافيّة، للقيام بغزوٍ شاملٍ للشرق، وإحكام السيطرة الاستعماريّة عليه.
الخلفيّة الثانية:
إنّ المستشرقين الذين كرّسوا حياتهم لدراسة كلّ ما يتعلّق بالإسلام ببُعدَيه الإيديولوجي والحضاري، قد تركّز في أذهانهم اعتقادٌ ثابت بأنّ الإسلام الأصيل
____________________
(١) د. خالدي ود. فروخ - التبشير والاستعمار في البلاد العربيّة: ٣٧.
يشكّل خطراً حقيقيّاً يقف سدّاً منيعاً أمام كلّ التطلّعات الاستعماريّة - لدُولهم الأُوربيّة - في الشرق، بل إنّه يحمل في واقعه النقيض الشامل لمدارسهم الفكريّة وكيانهم الحضاري، ويهدّد بالزوال كلّ وجودهم القائم على أساسها، لما يملكه من عمقٍ وواقعيّة وشموليّة مَنَحته وتمنحه القدرة الفائقة على التغيير، والامتداد إلى أيّ مجتمعٍ إنساني يجد طريقاً للنفوذ إليه.
وإلى هذا يشير لورانس براون بصراحة في كتابه الذي أصدره عام ١٩٤٤م قائلاً: (إنّ الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام وفي قدرته على التوسّع والإخضاع وفي حيويّته. إنّه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوربي). ويضيف براون في مناسبةٍ أُخرى قائلاً: (إذا اتّحد المسلمون في إمبراطوريّة أمكن أنْ يصبحوا لعنةً على العالم وخطراً،... أمّا إذا بقوا متفرّقين فإنّهم يظلّون حينئذٍ بلا وزن وتأثير)(١) .
وبنفس المضمون نشرت مجلّة العالم الإسلامي The Muslim World - الاستشراقيّة التي تصدر في لندن - في عددها المؤرّخ في حزيران سنة ١٩٣٠م ما نصّه: (إنّ شيئاً من الخوف يجب أنْ يسيطر على العالم الغربي، ولهذا الخوف أسباباً منها: إنّ الإسلام منذ أنْ ظهر في مكّة لم يضعف عدديّاً، بل هو دائماً في ازدياد واتّساع، ثمّ إنّ الإسلام ليس ديناً فحسب(٢) ، بل إنّ من أركانه الجهاد. ولم يتّفق قطّ أنّ شعباً دخل في الإسلام ثمّ عاد نصرانياً)(٣) ، ولعلّ المستشرق الألمانيكارل بيكر كان أكثر صراحة حينما قال: (إنّ هناك عداءً من النصرانيّة للإسلام، بسبب
____________________
(١) C F pown ٣٧ , Islam And Missions : ٤٤-٤٨ عن د. خالدي، مصطفى ود. فروخ، عمر - التبشير والاستعمار في البلاد العربيّة: ٣٧.
(٢) يقصد - حسب عقيدتهم - أنّ الدين هو الذي ينحصر في إطار الكنيسة والطقوس المقرّرة من قبلها فقط، لا كما نعتقد من أنّ الدين - كما هو الإسلام - عقيدةٌ ونظامٌ شاملٌ لكافّة أبعاد الحياة وجوانبها.
(٣) عدد يونيو سنة ١٩٣٠م تحت عنوان (الجغرافيّة السياسيّة للعالم الإسلامي).
The political Geography of The Mohammadan Word
أنّ الإسلام عندما انتشر في العصور الوسطى أقام سدّاً منيعاً في وجه انتشار النصرانيّة، ثمّ امتدّ إلى البلاد التي كانت خاضعةً لصولجانها)(١) .
الخلفية الثالثة:
إنّ منهجيّة البحث الاستشراقي ومنطقه عبارة عن محاكاة الماديّة الوضعيّة ومنهج العلمانيّة الضاربة في صميم الوجود الغربي، وإنّ رؤيته منتزعة من بيئة تلك المنهجيّة الغربيّة، لذلك فقد كانت الدراسات الاستشراقيّة بعيدة كلّ البعد عن المسلك الإلهي، والمنطق العقلي الذي تتميّز به المدرسة الإسلاميّة، إنْ لم نقل إنّها جاءت مشبّعة بالروح الماديّة التي تتحكّم في طريقة تفكير تلك المجتمعات، وبهذا الصدد يرى(دينيه) (٢) مثلاً: (إنّه من المتعذّر إنْ لم يكن مِن المستحيل أنْ يتجرّد المستشرقون عن عواطفهم وبيئتهم ونزعاتهم المختلفة...، وإنّهم لذلك قد بلغ تحريفهم لسيرة النبيّ والصحابة مبلغاً يُخشى على صورتها الحقيقيّة من شدّة التحريف فيها.
ورغم ما يزعمون من اتّباعهم لأساليب النقد البريئة ولقوانين البحث العلمي الجادّ، فإنّنا نلمس من خلال كتاباتهم محمّداً (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يتحدّث بلهجةٍ ألمانيّةٍ إذا كان المؤلّف ألمانيّاً، وبلهجةٍ إيطاليّةٍ إذا كان الكاتب إيطاليّاً، وهكذا تتغيّر صورة محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بتغيّر جنسيّة الكاتب.
وإذا بحثنا في هذه السيرة عن الصورة الصحيحة فإنّنا لا نكاد نجد لها من أثر. إنّ المستشرقين يقدّمون لنا صوراً خياليّةً هي أبعد ما تكون عن الحقيقة. إنّها أبعد عن الحقيقة من أشخاص القصص
____________________
(١) راجع د. محمّد البهي في (الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي): ٥٢٧. وراجع أيضاً جريدة البلاغ الكويتيّة العدد ٥٨: ١٢. وراجع أيضاً مجلّة البعث الإسلامي الهنديّة العدد ٩، السنة الثامنة.
(٢) هو (ألفونس أتيان دينيه)، وهو عالم مستشرق درس الشرق ونتاجه دراسةً عميقةً حتّى اهتدى إلى الإسلام واعتنقه، وأصبح سيفاً من سيوفه يدافع عنه ويردّ الشُبه والمكائد التي يثيرها أعداؤه (من بحث للدكتور شوقي أبو خليل).
التأريخيّة التي يؤلّفها أمثال (وولتر سكوت)(١) ، و(الكسندر دوماس)(٢) . وذلك أنّ هؤلاء يصوّرون أشخاصهاً من أبناء قومهم، فليس عليهم إلاّ أنْ يحسبوا حساب اختلاف الأزمنة. أمّا المستشرقون فلم يُمكنهم أنْ يُلبسوا الصورة الحقيقيّة لأشخاص السيرة، فصوّروهم حسب منطقهم الغربي وخيالهم العصري)(٣) .
إنّ من الأُمور التي باتت واضحةً اليوم هي ارتباط المنهج - كرؤية فكريّة وطريقة للعمل - بالموقف الفكري والثقافي من حيث الانتماء والهويّة، وهذه العلاقة لا تُستثنى في حقلٍ دون حقل، ولا في طريقةٍ دون أُخرى.
فخلاصة الخلفيّات السالفة الذكر هي: أنّ جهود المستشرقين وثمرات حركتهم تصدر جميعاً وفق أهدافٍ مشخّصة سلَفاً، وتقع - عند التأمّل - على نسقٍ واحد يتمثّل في موقفهم الفكري والثقافي، وما يلزمه من دفاع عن الهويّة الأُوربيّة بصورةٍ عامّة. ولهذا السبب نجدهم قد جانبوا الحق، فأوقعوا الكذب والاختلاف في دراساتهم، فكانت أساليبهم لا تُنبئ عن أمانتهم وصدقهم في مجالات البحث العلمي، مترسّمين هدفهم الراسخ أوّلاً وقبل كلّ شيء وهو: تمهيد الأرضيّة لعالميّة أوربّا وسيطرتها كقاعدة، فأسّست عليها الحركة الاستشراقية العالميّة.
____________________
(١) سكوت (وولتر): (١٧٧١ - ١٨٣٢م)، شاعر وروائي اسكتلندي من أشهر رواياته (آيفنهو) و(ابنة الجرّاح) (موسوعة المورد ٩: ١٠).
(٢) دوماس (ألكسندر) روائي فرنسي (١٨٠٢ - ١٨٧٠م)، وضع عدداً كبيراً من الروايات التاريخيّة. من أشهر رواياته: (الفرسان الثلاثة) و(الكونت دي مونت كريستو) (موسوعة المورد ٤: ٧).
(٣) دينيه (محمّد رسول الله) المقدّمة: ٢٧ و٢٨، و٤٣ و٤٤.
المدارس الاستشراقيّة
عندما نريد أنْ نشخّص الأهداف الحقيقيّة للاستشراق كحركةٍ لها مراحلها وأدوارها، لا بدّ من استقراء الواقع الميداني الفعلي لها، ضمن خلفيّاته التاريخيّة ومناطق نموّه التي وُلِد وترعرع في أحضانها. وعليه فقد ارتأينا أنْ نصنّف الاستشراق إلى مدارس تعتمدأوّلاً على جنسيّة المستشرق وانتمائه إلى وطنه الأُم.وثانياً على مراكز التنظير والجهد الاستشراقي، وذلك لما لهما من تأثير على الطرح الاستشراقي للمدرسة المعنيّة. وسوف ينعكس تقويمنا للجهد الاستشراقي من خلال:
١ - استعراض أبرز الشخصيّات التي عملت في هذا الحقل، وكانت بحق من الروّاد الحقيقيّين لتلك المدرسة.
٢ - المصبّات الموضوعيّة الأساسيّة التي وقع الجهد الاستشراقي عليها.
٣ - نماذج مختارة من الجهد الموسوعي للمستشرقين، التي تعتبر من المصادر العلميّة المهمّة عند الكثير من الباحثين المؤرّخين. مع أنّنا سوف نبيّن الخلط والابتعاد عن الروح العلميّة في أغلب الموارد التي تعرّضت لها هذه الموسوعات.
ويمكن أنْ نقسّم المدارس الاستشراقيّة إلى نوعين:
الأول: المدارس الرئيسيّة ذات التأثير المستقل الفاعل على الدراسات
والبحوث الاستشراقيّة العالميّة، والتي لم تكن أنشطتها تقتصر على الجوانب العلميّة فحسب، بل امتدّت لتشمل الجوانب السياسيّة والاقتصادية والاجتماعيّة، ورسمت الكثير من الخطوات على طريق الأحداث والتغييرات السياسيّة وملحقاتها في العالم.
الثاني: المدارس الثانويّة التي لم يكن لها الثقل المهم في مجمل الحركة الاستشراقيّة، أو التي انحصرت أنشطتها في فَتَرات زمنيّة محدودة، أو كانت لها أنشطة مشتركة مع إحدى المدارس الرئيسيّة، بحيث كانت تأثيراتها تصبّ ضمن أهداف تلك المدرسة.
وفي مجال الإحاطة بالأهداف العامّة للمدارس الاستشراقيّة، يمكننا اعتبار المدرسة الاستشراقيّة الفرنسيّة نموذجاً محقّقاً لها؛ لأنّها تجسّد لنا بشكل شمولي ونوعي، من خلال ملاحظتها ودراستها، كافّة الأبعاد الأساسيّة للجهد الاستشراقي لجميع المدارس الاستشراقيّة الأُخرى، ممّا يجعل انتخابها وأفرادها بالدراسة قائمٌ على أساس الضرورة الموضوعيّة، التي تبرز الأهم والأخطر والأكثر عمقاً من بين غيرها من المدارس، ممّا سيساهم بدرجةٍ كبيرة في تسليط الضوء على الهدف من دراسة الاستشراق، وهو كشف دوره في حركة الاستعمار الأوربّي للشرق الإسلامي، بِبُعديه الفكري والميداني، وتزامنه مع حركة الاستعمار العسكري وغزوه الحضاري لهذه المنطقة، والذي من أبرز معالمه جملة من النظريات والأُطروحات المُستحدثة التي تلبّست بالقوميّة أو الوطنيّة تارة، وبالتمدّن والتحديث تارةً أُخرى، وبالدفاع عن حقّ الشعوب تارةً ثالثة.
وعلى الرأس مِن هذه وتلك زرعُ الكيان الصهيوني الغاصب في قلب العالم الإسلامي، وجعله بؤرةً للقلق والاضطراب في المنطقة، ومركزاً لتحقيق الأطماع الاستعماريّة والطموحات الاستكباريّة.
النموذج: المدرسة الاستشراقيّة الفرنسيّة
يمكن القول: إنّ المعالم الرئيسيّة للمدرسة الاستشراقيّة الفرنسيّة قد بدت واضحةً بعد فشل الحروب الصليبيّة التي شنّها الغرب المسيحي على المسلمين، والتي كان لفرنسا الحظّ الأوفر في اندلاعها وقيادتها، قرابة ثلاثة قرون انتهت بطرد الإفرنج تماماً من الأراضي العربيّة الإسلاميّة على يد المماليك في أواخر القرن الثالث عشر.
ولعلّ ما نادى به لويس التاسع(١) بعد فشله في إحدى الحملات الصليبيّة دليلٌ على أنّها كانت أرضاً خصِبة لنموّ الاستشراق، ممّا ساعد على تأسيس مدرسة كان لها الدور الكبير في رفد الحركة الاستشراقيّة العالميّة.
وليس من باب المصادفة أنْ تكون أوّل ترجمة للقرآن الكريم قد تمّت في فرنسا، وبقيت محفوظةً في دير كلوني بجنوبي فرنسا حتّى سنة ١٥٤٣م، ولا بدون قصد أنْ تبدأ مرحلة التنظيم الفعلي لحركة الاستشراق من فرنسا في مطلع القرن الثامن عشر، وأنْ يعقد أوّل مؤتمر عالمي للمستشرقين في باريس عام ١٧٨٣م. كما أنّ أوّل جمعيّة
____________________
(١) لويس التاسع، (١٢١٤ - ١٢٧٠م) أشهر الملوك الفرنسيّين، قاد الحملتين: السابعة التي وصل فيها إلى دمياط عام ١٢٤٩م، وأُسر في معركة المنصورة عام ١٢٥٠م، وانقلب إلى فرنسا بعد أربع سنوات، وقاد الحملة الصليبيّة الثامنة ولكنّه مات بالطاعون في تونس بُعَيد مغادرته فرنسا عام ١٢٧٠م. (المنجد في الأعلام، وموسوعة المورد ٦: ١٤٦).
للمستشرقين تأسّست في باريس باسم جمعيّة باريس الآسيويّة Sociote Asiatique De paris في سنة ١٨٢١م، التي أصدرت دوريّتها تحت اسم (المجلّة الآسيويّة) Asiatique Journal في سنة ١٨٢٢م.
المميّزات الأساسيّة للمدرسة الاستشراقيّة الفرنسيّة
مِن الواضح لمتتبّعي شؤون الحضارات الإنسانيّة، أنّ لأوربّا حضارةً خاصّة تتميّز بها عبر تأريخها الطويل، إلاّ أنّ الذي نريد أنْ نضيفه هنا أو نؤكّد عليه هو أنّ لبعض الشعوب الأوربيّة - خصوصاً الكبيرة منها - بعض الخصائص الحضاريّة التي تتميّز بها عن غيرها من شعوب أوربّا، تدفعنا لأخذها بنظر الاعتبار ضمن المؤثّرات الإيديولوجيّة على موضوع دراستنا للاستشراق، وبعبارة أُخرى: إنّ منهج دراستنا للمدارس الاستشراقيّة التي برزت على سطح الواقع الميداني سيتمّ على ضوء تشخيصنا المُسبق للخصائص الإضافيّة لبلد ومجتمع المدرسة الاستشراقيّة التي نشأت فيه وترعرعت في أجوائه الحضاريّة.
إذن فالتمييز بين مدرسة استشراقيّة وأُخرى سوف لا يلحظ في جانبه الميداني جغرافيّاً فقط، بل يلحظ في جانبه الميداني حضاريّاً أيضاً، والمدرسة الفرنسيّة للاستشراق ممّا ينالها نصيب بارز من هذا اللحاظ، وباستقرائنا للنماذج البارزة من المستشرقين الفرنسيّين في إطار التأريخ الفرنسي يمكننا استخلاص المميّزات الأساسيّة التالية لهذه المدرسة:
١ - العداء والحقد للإسلام ديناً وللحضارة الإسلاميّة بمختلف معطياتها، وانعكاساتها وامتداداتها الزمانيّة والمكانيّة: ويُعزى ذلك إلى الصراع الطويل
الذي كان محتدماً بين الطرفين إثر استيقاظ فرنسا بشكلٍ خاص، وأوربّا بشكلٍ عام على صوت الإسلام والدعوة الإسلاميّة، حيث كانت غارقةً في وحشيّة القرون الوسطى والحروب القبليّة، والصراعات بين الأُمراء والنُبلاء والملوك، وحيث تحكم الكنيسة بأفكارها الخرافيّة وسيطرتها على مراكز القرار، وابتداع أساليب الظلم والجور باسم الدين المسيحي.
في هذه الفترة المظلمة جاء الإسلام بمثابة حافزٍ ومنبّهٍ عظيم لإيقاظ الفرنسيّين بالخصوص؛ لأن الدولة الإسلاميّة أصبحت قريبةً ومجاورةً للجسد الأوربّي (في إسبانيا والبحر الأبيض المتوسّط وجنوبه)، وهي تحمل فكراً جديداً وعقيدةً ساطعة. فلم يكن من الكنيسة وملوك فرنسا إلاّ أنْ يشحنوا الفرنسيّين بالعداء للمسلمين على أنّهم كَفَرة برابرة يجب مواجهتهم بعنفٍ دموي، وسحقهم وإبادتهم.
وابتدأت المعارك فكانت (بلاط الشهداء) المعركة الأولى عام ٧٣٢م التي مهّدت للحروب الصليبيّة، حتّى تمكّن الفرنسيّون عام ١٠٩٩م من دخول القدس بقيادة (غودفري دي بويون)(١) . ولم تكن هذه هي المعركة الوحيدة التي خاضها الفرنسيّون ضدّ المسلمين، فقد قاد الفرنسيّون وحدهم خمسَ حملات صليبيّة كان آخرها الحملة الصليبيّة الثامنة عام ١٢٧٠م، التي قادها لويس التاسع، وقد مُنيت بالفشل الذريع.
إنّ هذا الصراع المرير قد انعكس على كافّة الجوانب الحيويّة للفرنسيّين، حتّى امتدّ إلى الحياة الأدبيّة والثقافيّة، وألقت بظلالها الثقيلة على الدراسات والبحوث التي تعالج قضايا الشرق عموماً، والإسلام بشكلٍ خاص، فجاء العديد
____________________
(١) غودفري دي بويون (١٠٦٠ - ١١٠٠م): أمير فرنسي اشترك في الحملة الصليبيّة الأولى (١٠٩٦ - ١٠٩٩م) وأسهم في حصار القدس، أوّل ملوك المملكة اللاتينيّة في بيت المقدس (١٠٩٩ - ١١٠٠م)، توفّي بعد أنْ أُصيب بحمّى التيفوئيد في أغلب الظن، عدّته الأساطير المتأخّرة (الفارس النصراني الأمثل). موسوعة المورد ٥: ٧.
من الدراسات محمّلاً بالتشويه المتعمّد لصورة الإسلام وشخصيّة النبيّ الأكرم محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، كما في كتاب (تاريخ فرنسا) للمستشرق الفرنسي (جوليمين) حيثُ جاء: إنّ محمّداً مؤسّس دين المسلمين قد أمر أتباعه أنْ يُخضعوا العالم، وأنْ يُبدّلوا جميع الأديان بدينه هو، ما أعظم الفرق بين هؤلاء الوثنيّين (المسلمين) وبين النصارى؟
إنّ هؤلاء العرب قد فرضوا دينهم بالقوّة وقالوا للناس أسلموا أو موتوا، بينما أتباع المسيح ربحوا النفوس ببرّهم وإحسانهم. ماذا كان حال العالم لو أن العرب انتصروا علينا؟ إذن لكنّا مسلمين كالجزائريين والمراكشيين(١) .
وعندما نلاحظ كتابات الفرنسيّين نراهم يضعون أنفسهم في أوربّا ثمّ ينظرون منها، فيعكسون وجهة نظر الغرب إلى الشرق الإسلامي، كما جاء في الدراسة التي أعدّها المستشرق الفرنسي اليهودي الأصل (مكسيم رودنسون) تحت عنوان (الصورة الغربيّة والدراسات الغربيّة الإسلاميّة)، نختار منها المقاطع التالية مصداقاً لما أشرنا إليه: (كان المسلمون يشكّلون تهديداً للعالم المسيحي الغربي قبل أنْ يصبحوا مشكلة بزمن طويل.
فقد حدث - في نظر الأوربيّين - تحوّل في القُوى في الأقسام البعيدة من الشرق، وقام شعبٌ هائج هُم (العرب أو السراسنة)(٢) ، عرف بالسلب والنهب، وهو علاوة على ذلك شعبٌ غير مسيحي، فاجتاح وخرّب أراضي واسعة، وانتزعها من قبضة المسيحيّة... ولقد وصلت
____________________
(١) جوليمين، (تاريخ فرنسا): ٨٠ - ٨١.
(٢) السراسنة: هذه الكلمة آتية من الكلمة اللاتينيّة Saracenus (نقلاً عن اليونانيّة Sarakenos )، وتطلق على المسلمين. وقد ظهر هذا الاصطلاح أوّل مرّة في مؤلّفات كتّاب القرن الأوّل الميلادي، وقصدوا به البدو الذين كانو يعيشون منذ أزمان طويلة على أطراف المناطق الزراعيّة ما بين النهرين، ويهدّدون طُرق التجارة أو يحمونها بتكليف من القوّتين العُظميَيَن يومذاك: الرومان والفرس، والكلمة في اليونانيّة تعني ساكني الخيام، وتستخدم في كتابات الأُوربيّين استخداماً يعطي معنى السلب والنهب والتدمير، ولا تطلق إلا على المسلمين.
(راجع تراث الإسلام ترجمة د. السمهوري، الهامش: ٢٨).
الكارثة أخيراً إلى إسبانياً والشواطئ الايطاليّة و(بلاد الغال) ، وكانت موجة البرابرة الغزاة ذاتها هي دائماً المسؤولة)(١) .
٢ - الروح الصليبيّة النصرانيّة كانت غالبة على معظم كتابات المستشرقين الفرنسيّين: حتّى لَيُمكن القول: إنّ المدرسة الفرنسيّة قد نصبت نفسها حاميةً للنصارى، رافعةً شعار الدفاع عن الشرقيّين منهم، مستخدمةً بذلك شتّى الوسائل والأساليب لتحقيق هذا الهدف، وهذا يفسّر لنا سرّ الإسفاف والسقوط في الافتراء الذي مارسه المستشرقون الفرنسيّون لتشويه الحقائق الإسلاميّة.
وممّا يحكي هذه الحقيقة، بل هو دليلٌ صريح عليها، ما جاء في كتابات المُستشرق الفرنسي(رودنسون) ما نصّه: (لقد برزت صورة الإسلام، ليس كما قال البعض بنتيجة الحروب الصليبيّة، بقدر ما برزت بنتيجة الوحدة الإيديولوجيّة، التي تكوّنت ببطءٍ في العالم المسيحي اللاتيني.
وقد أدّت هذه الوحدة إلى رؤيةٍ أوضح لمعالم العدوّ، كما أدّت إلى تضافر الجهود نحو الحروب الصليبيّة، وفي القرن الحادي عشر وبنتيجة زيارات الحجّاج المتزايدة في العدد وفي التنظيم للأرض المقدّسة (في فلسطين)، والتي كانت قد تحوّلت إلى هَجَمات مسلّحة ضدّ (البدو أصحاب السلب والنهب) (المسلمين)، توطّد لدى الأوربيّين المثل الذي يُمكن أنْ يُحتذى للدخول إلى الأرض المقدّسة.
كما أنّ القيمة الأُخرويّة للقدس وللقبر المقدّس الذي دنّسه وجود الكفّار، والقيمة التطهيريّة للحجّ، والفكرة القائلة بأنّه من الواجب تقديم العون للمسيحيّين الشرقيّين الذين أُذِلّوا، كانت كلّها من الأُمور التي أدّت إلى جعل الحملة على الأرض المقدّسة واجباً مقدّساً يُوضع نصب أعيُن
____________________
(١) رودنسون، مكسيم: (تراث الإسلام)، القسم الأوّل. تصنيف: شاخت وبوزورث، ترجمة: د. السمهوري: ٢٧ و٢٨.
المؤمنين (المسيحيّين)(١) .
٣ - تعميق الروح العنصريّة للثقافة الفرنسيّة في الدراسات الاستشراقيّة، وإبراز التراث والتاريخ الفرنسي بشكلٍ مبالغ به، والتمجيد بحضارة الإغريق التي تنتمي لها فرنسا، والحطّ من قيمة الحضارة الإسلاميّة والعربيّة، والتقليل مِن شأن اللغة العربيّة (لغة القرآن الكريم).
وهنا لابدّ من الإشارة إلى نقطة جوهريّة وهي: أنّ الثقافة الفرنسيّة المعدّة للتصدير، والتي سرت إلى تنظيرات الدراسات الاستشراقيّة، هي ثقافةٌ نصرانيّة خالصة، بل هي تجهّز وتُعدّ إعداداً خاصّاً للتصدير إلى الأمّة الإسلاميّة.
تقول جريدة(لاستامبا) الايطاليّة النصرانيّة عن ذلك: (إنّ وطنيّة الرهبانيّات الفرنسيّة في المشرق هي وطنيّة نقيّة وغيورة، والثقافة التي تنشرها هي ثقافة مسيحيّة خالصة وفرنسيّة واضحة، إنّها قبل كلّ شيء ثقافةٌ فرنسيّة، ومن ثمّ مسيحيّة، لقد أصبحت فرنسا سيّدة...)(٢) .
وقد ذكر ذلك الشاعر الباكستاني المعروف محمّد إقبال، حيث قال: (إنّ سحر الإفرنج أو فنّه - ثقافته - أذاب الصخور وأسالها ماء)(٣) .
والشواهد كثيرةٌ لبيان تأثير التعصّب للثقافة الفرنسيّة على المدرسة الاستشراقيّة الفرنسيّة، منها كتاب(مجد الإسلام) للمستشرق الفرنسي (جاستون فييت).
والذي يلفت النظر في أغلب كتب المستشرقين هذه هو: العناوين البرّاقة لكتبهم والتي تخالف المضمون الحقيقي لها بشكلٍ كامل، ولعلّها إحدى الأساليب
____________________
(١) رودنسون، مكسيم (تراث الإسلام)، نصنيف: شاخت وبوزورت، ترجمة: د. السمهوري: ٣١.
(٢) مجلّة المنتقى، العدد الأوّل، نقلاً عن مجلّة لاستامبا الايطاليّة.
(٣) الندوي، أبو الحسن (الصراع بين الفكرة الإسلاميّة والفكرة الغربيّة): ١٧٢.
لخداع القرّاء المسلمين، حيثُ إنّ العنوان المتحقّق يخفي بين طياته سموما تعمل عملها في نفسيّة القرّاء وأذهانهم. فكتاب (مجد الإسلام) مثلاً الذي أشرنا إليه يبدأ من فصله الأوّل حتّى نهايته بترديد أفكارٍ مشوّهة عن الإسلام، وعن الرسول محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وعن التاريخ الإسلامي، طالما قد تكرّرت في كثير من كتب المستشرقين.
فمثلاً عندما يتحدّث الكاتب عن التاريخ الإسلامي لا يذكر إلاّ الوقائع والحروب فقط، وقيام الدولة الإسلاميّة وسقوطها، وقد فاته أنّ للمسلمين تأريخاً آخر غير هذه السلسلة الطويلة من الوقائع والحروب، فاته تاريخ المجتمع الإسلامي كيف نشأ وكيف قام، وكيف تطوّر وشيّد حضارةً امتدّ إشعاعها إلى أوربّا بالذات، في وقت كانت غارقة في ظلمات الجهل والانحطاط، كما لا يتناول تاريخ اللغة العربيّة، وكيف سارت من الخليج إلى المحيط.
فليس بين فصول الكتاب ذكر لنواحي حضارتنا الإسلاميّة، أو أثر لتراثنا ودوره العلمي في انتشار الإسلام، وكلّ ما هناك هو أنّه يقف في نهاية الكتاب - وهو بيت القصيد - فيقول: (إنّ الحضارة الإسلاميّة ركدت لأنّها لم تقم على أساس حضارة اليونان)(١) .
وسنشير فيما بعد إلى أمثال هذه النماذج عند الدخول في تفصيل دراسة الجهد الاستشراقي إنْ شاء الله.
٤ - نزعة التعصّب ألاستكباري التي نجدها مهيمنة على أغلب الدراسات الاستشراقيّة للمدرسة الفرنسيّة، وقد أشرنا إلى هذا المعنى سابقاً في باب (هوية الاستشراق) بما كتبه المستشرق الفرنسي(هانوتو) الذي كان يعمل مستشاراً
____________________
(١) من دراسة حول كتاب (مجد الإسلام) للأستاذ الدكتور حسين مؤنس، أُستاذ التأريخ الإسلامي بجامعة القاهرة، نشرت بالملحق الأدبي لجريدة الأهرام (أهرام الجمعة)، وتتضمّن عرضاً وتحليلاً ومناقشة للفكر الاستشراقي يبيّن واقع إنتاجه العلمي.
لوزارة المستعمرات الفرنسيّة حيثُ قال: (إنّ شعباً جمهوريّ المبادئ (شعب فرنسا) يبلغ عدد نفوسه أربعين مليوناً لا مرشد له إلاّ نفسه، لا عائلات ملوكيّة فيه يتنازعنَ الحكم، ولا رؤساء يتناولون الرئاسة بطريق الوراثة، هو الذي تقلّد زمام إدارة شعبٍ آخر لا يلبث أنْ ينمو حتّى يساويه في العدد، وهو ذلك الشعب المنتشر في الأرجاء الفسيحة والأصقاع المجهولة، والمتّبع لتقاليد وعادات غير التي نَعنُو لها ونحترمها... وهو الشعب الإسلامي السامي الأصل، الذي يحمل إليه الشعب الآري المسيحي الجمهوري الآن ملح المدنيّة وروحها)(١) .
ويُمكن أنْ نستطلع رأي مستشرق فرنسي آخر وهو (مكسيم رودنسون) الذي يُعتبر أحد أركان مدرسة الاستشراق الفرنسيّة، والذي يتجلّى بالبزّة العنصريّة الاستكباريّة بشكلٍ لا يقبل الشك حيث يقول: (وهكذا بعد أنْ أصبح القتال أكثر تركيزاً وتوجيهاً، كان لابدّ مِن إعطاء العدو صفات أوضح وأدق، وكان لابدّ من تبسيط صورته وإعطائها طابعاً نمطيّاً.
كان (السراسنة) - يقصد بهم المسلمين - بالنسبة للحجّاج - المسيحيّين - مجرّد أعداد زائدة لا وجود لها، ومجرّد كفّار تافهين، حكّام بحكم الأمر الواقع، يتحرّك المرء بينهم بلا مبالاة... وفي الواقع لم تكن لدى أوربّا المسيحيّة صورةٌ واحدة عن العالم المعادي الذي كانت في صِدام معه، بل كانت لديها عدّة صور...)(٢) .
إنّ الاستكبار الأوربّي لعِب دوراً كبيراً في تحديد طبيعة النظرة الأوربيّة إلى الشرق الإسلامي، وخصوصاً بعد منتصف القرن التاسع عشر.
يقول المستشرق رودنسون: (لقد كان التفوّق الأوربّي من النواحي الاقتصاديّة والفنيّة والعسكريّة والسياسيّة والثقافيّة طاغياً، في الوقت الذي كان فيه الشرق يغرق في التخلّف
____________________
(١) د. محمّد البهي (الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي): ٣٢.
(٢) رودنسون، مكسيم (تراث الإسلام) تصنيف، شاخت وبوزورث: ٣١ و٣٢.
وأصبحت إيران والإمبراطوريّة العثمانيّة - عمليّاً - محميّتين أوربيّتين)(١) .
لقد أرادت فرنسا أنْ تكون حاملة للواء العظمة الأوربيّة في العالم، وانعكست هذه الإرادة على الثقافة الاجتماعيّة والرأي العام للمجتمعات الشرقيّة، فأصبح كل ما من شأنه أنْ يفتح نافذة التطلّع نحو الإسلام أو العودة إلى تحكيمه، أو دراسة منهجه الأصيل وتأثيره في العالم الإسلامي ضرباً من الجمود والتحجّر، ونزوعاً نحو الرجعيّة والتخلّف والتعصب.
وهذه هي صورة التطلّعات الإسلاميّة في نظر المستشرقين الفرنسيّين، أو هكذا يصوّرونها للآخرين من خلال كتاباتهم ومناهج عملهم.
فمثلاً، عندما تأسّست (حركة الجامعة الإسلاميّة)(٢) في القرن التاسع عشر كردّة فعل للاستعمار الأوربّي، وازدياد نفوذ دوله على حساب الدول الإسلاميّة، تعالت صرخات الغرب والأوربيّين بشكلٍ خاص في وجه هذه الحركة.
وبفعل الوسائل الإعلاميّة والثقافيّة كالصحافة والأدب والفنون الأُخرى استطاعت هذه الدول الاستعماريّة توجيه المجتمع الأوربّي ورأيه العام ضدّ هذه الحركة، وقد كتب أحد المستشرقين الفرنسيّين في ذلك قائلاً: (كانت حركة الجامعة الإسلاميّة ( pan – Islamism ) هي الغول المرعب في ذلك العصر، على نفس الطريقة وفي نفس الزمن اللذين انتشر الرعب فيهما من (الخطر الأصفر)(٣) ، وكانت هذه الكلمة -
____________________
(١) مجلّة رسالة الجهاد، العدد ٧٠، السنة السابعة: الاستشراق في الميزان: ٥٩.
(٢) حركة ظهرت في القرن التاسع عشر، واستهدفت توحيد المسلمين في دولةٍ كبرى على رأسها خليفة قادر على وقف الغزو النصراني للديار الإسلاميّة، يعتبر جمال الدين الأفغاني أبرز الداعين إليها، وقد رعاها السلطان عبد الحميد الثاني، وشنّ حملة واسعة للتبشير بها، بيد أنّ أثرها ضعف وتضاءل إثر سقوطه عام ١٩٠٩م. وهي غير الجامعة الإسلاميّة المُحدثة التي تأسّست بعد الحرب العالميّة الثانية. (عن موسوعة المورد ٧: ١٩٨).
(٣) يُزعم أنّه ناشئ عن تعاظم قوّة العرق الأصفر بملايينه التي تفوق الحصر، وقد يطلق على العرق الأصفر نفسه بوصفه مصدر هذا الخطر. (عن موسوعة المورد ١٠: ١٨٥).
حركة الجامعة الإسلاميّة - نفسها توحي بالتطلّع الإسلامي للسيطرة وبإيديولوجيّةٍ عدوانيّة، وبمؤامرةٍ على نطاق عالمي)(١) .
نشأة المدرسة الاستشراقيّة الفرنسيّة وعوامل نموّها وتطوّرها
إنّ تاريخ نشوء المدرسة الفرنسيّة للاستشراق يرجع في بداياته الأُولى إلى الفترة الزمنيّة، التي بدأت بها فرنسا الاحتكاك بالشرق الإسلامي، مع بداية ظهور الإسلام في شمال إفريقيا، ثمّ أعقبته المداخلة الميدانيّة في إسبانيا بعد إسقاط الدولة البيزنطيّة، وتأسيس دولة الأندلس في نفس الفترة الزمنيّة التي ابتدأ بها القساوسة والرهبان الأوربيّون يتّجهون صوب دراسة وترجمة الفكر والثقافة الإسلاميّة، مجنّدين لهذا الهدف العديد من العلماء والمفكّرين الأوربيّين.
كالذي قام به بطرس الموقّر رئيس رهبان كلوني(٢) (١٠٩٤ - ١١٥٦)، من أجل الحصول على معرفة علميّة موضوعيّة عن الفكر الإسلامي، منطلقاً من موطنه فرنسا لنقل هذه المعرفة إلى كلّ أوربّا، تلك المعرفة التي حصل عليها بطرس الموقّر بصورةٍ مباشرةٍ أو غير مباشرة، قد تأتّت من خلال نشاطاته وزياراته لأديِرةِ رهبنتهِ في إسبانيا - عندما كانت تحت الحكم الإسلامي، عن القضايا الإسلاميّة ونشاط التراجمة. وممّا زاد
____________________
(١) CF J – J. Wardenburg, L,Islam Dans Le Miroir De I, Occident (paris – The Hague, ١٩٦٣ ), pp. ١٠٢ – ٦.
(٢) كلوني: مدينة في شرق فرنسا أُسس فيها الدير المعروف باسمها سنة ٩١٠م، وهو من أشهر الأديرة الرهبانيّة في التاريخ الأوربّي الوسيط في منطقة الصون - اللوار في فرنسا - وانطلقت من هذا الدير حركة إصلاح دينيّة رهبانيّة، امتدّت في القرن الحادي عشر والثاني عشر من فرنسا إلى كلّ المسيحيّة الأوربيّة، وقد لعب هذا الدير دوره في التحريض على الصليبيّات وفي إيصال عدد من رهبانه إلى سدّة البابويّة - (تراث الإسلام): ٣٧.
من تشبّثه بمشروعه هو اهتمامه بمحاربة الهرطقات (حسب رأيه) المتمثّلة باليهوديّة والإسلام (وإنْ يكن ذلك بجديّة ومحبّة إزاء الأفراد (الضالّين) بما ينسجم مع شخصيّة رئيس رهبان كلوني).
وبسبب أنّه كان مُدرِكاً بعمق الأخطار التي كانت تواجهها الكنيسة في عصرٍ تميّز بالاضطراب الفكري والانشقاق، لذلك فقد رغب أنْ يسلّح الكنيسة ضدّ هذه الأخطار، منطلقاً من اعتقاده الشخصي أنّه رئيس لرهبنة مكرّسة لهذا الهدف.
ويبيّن بطرس الموقّر الهدف من مشروعة - الاستشراقي - الذي كرّسه ضدّ الإسلام، في معرض ردّه على بعض من اقترح عليه عدم جدوى عمله حيثُ يقول: (إذا كان عملي يبدو عديم الفائدة؛ لأنّ العدوّ يبقى منيعاً ضدّ مثل هذه الأسلحة، فإنّي أُجيب أنّه في بلاد ملك عظيم تكون بعض الأشياء من أجل الحماية، وأُخرى للزينة، وأُخرى أيضاً للغرضَين معاً.
لقد صنع سليمان المسالم أسلحة للحماية، لم تكن هناك حاجة إليها في أيّامه، وقام داود بإعداد الزينة للمعبد، وإنْ كان استعمالها متعذّراً في أيّامه... وهذا العمل كما أراه لا يُمكن أنْ يُقال إنّه عديم الفائدة.
فإذا تعذّر هداية المسلمين (الضالّين) به فإنّ العلماء الذين يغارون على العدالة يجب أنْ لا يفوّتهم تحذير أُولئك الضعفاء من أفراد الكنيسة الذين يروَّعون أنْ يثأروا عن غير ما قصد بالقضايا التافهة).
وامتدّت نشاطات الموقّر من فرنسا إلى إسبانيا حيثُ شكّل جماعة مِن التراجمة يعملون تحت إشرافه، وترجموا القرآن الكريم عام ١١٤٣م، ومجموعة من النصوص العربيّة الأُخرى وأعدّوا مؤلّفاً لتعليمات بطرس الموقّر نفسه، على أنّ هناك قولاً آخر يؤرّخ النشوء مع بدايات الصراع العسكري الصليبي، والحملات الصليبيّة ضدّ المسلمين وبخاصّة بعد الصرخات المُعادية التي أطلقها لويس التاسع سنة ١٢٥٠م.
ورغم ما يُمكن أنْ يُقال من أنّ هذه البدايات والظواهر لا تختص بالمدرسة الفرنسيّة وحدها، بل هي بدايات وظواهر مشتركة في قيام جميع المدارس الاستشراقيّة ونشوئها، إلاّ أنّه يمكننا أنْ نجعل الخصوصيّة هنا للمدرسة الفرنسيّة في أنّ أوّل كرسي للعربيّة تأسّس عام ١٥٣٩م، واقترن بأوجّ ما وصلت إليه الحروب الصليبيّة، كان في (الكالج دو فرانس غليوم بوستل(١) ، العالم المستنير - حسب وصف رودنسون - الذي درّب تلاميذ عديدين مِن أمثال (سكاليجر) الذي كانت مكانته في مجال الاستشراق لا يُستهان بها(٢) .
إنّ الحروب الصليبيّة وتأثيرات التحريض الكنسي العنصري، بالإضافة إلى التطلّعات الاستكباريّة الفرنسيّة، وانهيار الدولة الإسلاميّة - لأسبابٍ كثيرة كان أهمّها تعرّضها لتلك الهجمات الوحشيّة التي قادتها أوربّا وخصوصاً فرنسا - أدّت إلى ظهور الاستشراق الفرنسي بصورته الحقيقيّة العنصريّة، وبمواقفه العدائيّة تجاه العالم الإسلامي.
حتّى أنّه كان في بعض الفترات - إنْ لم نقل في معظمها - يداً قويّة للاستعمار الفرنسي، كما سيتوضّح ذلك في محلّه إنْ شاء الله.
لقد أفادت المدرسة الاستشراقيّة الفرنسيّة من الحروب الصليبيّة أيّما فائدة،
____________________
(١) بوستل غليوم (١٥١٠ - ١٥٨١م). مستشرق ورحّالة فرنسي ألّف كتاباً في أبجديّات اثنتي عشرة لغة، منها اللغة العربيّة - المنجد في الأعلام.
(٢) رودنسون، مكسيم - تراث الإسلام ق١: ٦٢.
حيثُ إنّ الثمار الايجابيّة لأوربّا وفرنسا التي تمخّضت عن هذه الحروب، أعطت دفعاً وزخماً للاستشراق الفرنسي؛ لأنّ دور هذهِ الحروب لم يقتصر فقط على ساحات القتال، بل تجاوز إلى ميادين أُخرى ثقافيّة وتبشيريّة وأخلاقيّة على طريق الكثير من المؤسّسات والجامعات التي مارست نشاطاً استشراقيّاً واضحاً، ولا سيّما أنّ الحروب الصليبيّة كانت تمرّ في بعض الأوقات بفترات هدنة وسلام، كانت فرصة مواتية استثمرها الفرنسيّون لصالحهم بقصد تدمير البناء الإسلامي من الداخل، وتخريب المجتمع الإسلامي بزرع الخلافات وإذكاء أُوار الصراعات الداخليّة التي أخذت تنهش في أوصاله.
إنّ الدراسات الشرقيّة التي شاعت في أوربّا زوّدت الفرنسيّين بكنوز من المعلومات، سُخّرت لخدمة المصالح الفرنسيّة، فكان كلّ شخص في أوربّا يرغب في التعرّف بشكلٍ وافٍ على لغات المشرق الأدنى وحضاراته، يتوجّه إلى مدرسة اللغات الشرقيّة الحيّة في باريس، التي أسّستها حكومة المؤتمر الثوريّة(الكونفانسيّون) في مارس سنة ١٧٩٥م بإيعاز من المستشرق (لانجليز)(١) .
إنّ الدراسة الفرنسيّة بلغت أوجّ عظمتها في بعض الفترات، فلمع فيها بعض الشخصيّات الاستشراقيّة التي كان لها دورٌ كبير في تطوير الاستشراق الأوربّي، فأصبحت باريس القبلة التي يؤمّها جميع المستشرقين الأوربيّين الذين يرغبون في التخصّص بدراسة الشرق الأوسط، ومن هذه الشخصيّات (سلفستر دوساسي) الذي لُقّب بأُستاذ جميع المستشرقين الأوربيّين في زمانه، وبقي أُسلوبه في العمل حتّى يومنا هذا، هو الأُسلوب نفسه الذي يتّبعه عدد كبير من المستشرقين. وفي
____________________
(١) مستشرق فرنسي (١٧٦٣ - ١٨٢٤م). تعلّم على المستشرقين الفرنسيّين كوسان دي برسفال، ودوساسي، ترجم قسماً من ألف ليلة وليلة، ورحلات العرب والفرس إلى الصين والهند في القرن العاشر - المنجد في الأعلام.
عهده كانت مدرسة باريس للّغات الشرقيّة - التي أشرنا إليها والتي قامت في أوجّ حماسة فرنسا الثوريّة، النموذج لمؤسّسة الاستشراق العلمي والعلماني، ومن جرّاء ذلك ظهرت كلمة مستشرق Orientoiliste في فرنسا عام ١٧٩٩م. وأُدرجت كلمة الاستشراق Orientoile في قاموس الأكاديميّة الفرنسيّة عام ١٨٣٨م، وأخذَت فكرة إيجاد فرع متخصّص من فروع المعرفة لدراسة الشرق تلقى المزيد من التأييد، ولم يكن هناك حتّى ذلك الوقت مختصّون بأعداد تكفي لتأسيس مجلاّت أو جمعيّات تهتم حصراً ببلدٍ واحد، أو بشعبٍ واحد أو منطقة واحدة في الشرق، وبدلاً من ذلك كان نطاق المجلاّت والجمعيّات يمتدّ ليشمل عدّة مجالات، وإنْ لم تحظَ جميعها بدرجةِ العمق نفسها في البحث(١) .
ويمكن أنْ نقول: إنّ الاستشراق الفرنسي بشكلٍ خاص قد نما وترعرع عندما جاءت مبادرته الميدانيّة، نتيجةً للأحداث المتعلّقة بالشرق الإسلامي، من حيث التغيّرات السياسيّة والنظرة الأوربيّة التي كانت تعتبر الشرق الإسلامي من المشاكل العظمى التي تواجه السياسة الأوربيّة بالخصوص في القرن التاسع عشر.
مناطق نفوذ المدرسة الاستشراقيّة الفرنسيّة
إنّ الاقتران الذي أكّدناه في حركة الاستشراق بالتبشير والاستعمار، يحتّم علينا جدلاً أنْ نجعل من مناطق النفوذ السياسي والثقافي لفرنسا مجالاً أساسيّاً للاستشراق الفرنسي، على نحو التمهيد أو الترسيخ لتلك الحركة السياسيّة والثقافيّة،
____________________
(١) رودنسون، مكسيم - تراث الإسلام ق١: ٧٨.
سواء أكانت على شكل عمل تبشيري بكافّة أبعاده الثقافيّة والدينيّة، أو نفوذ اقتصادي أو استعمار عسكري مباشر. ومن خلال استعراض الجغرافية السياسيّة لمناطق النفوذ الفرنسي نجدها تحتلّ رقعةً واسعةً ومهمّة من مناطق الوطن الإسلامي ابتداءً من سواحل شمال إفريقيا (الجزائر، المغرب، تونس، مصر) إلى وسطها الذي يسمّى بالسودان الفرنسي، بما فيها جيبوتي والسنغال وموريتانيا وتشاد ومالي وغينيا، والنيجر وكانم البرتو والغور والحوصة وسنغاي، ومن غرب آسيا المتمثّل ببلاد الشام (سوريا ولبنان إلى شبه القارة الهنديّة).
وقد بدأ الاستشراق الفرنسي عمله الميداني المباشر عندما اكتُشف رأس الرجاء الصالح عام ١٤٨٨م، فتدفّق المستشرقون بعناوينهم المتعدّدة، علماء ومنقّبين عن الآثار ومبشّرين للنصرانيّة. وقد سبق هذا الانتشار افتتاح مراكز للتبشير في إفريقيا السوداء، كان أوّلها في الكونغو عام ١٤٩١م، فعملت على التعرّف على هذه القارّة، والتمهيد بالتعاون مع عصابات تجّار الرقيق لدخول فرنسا بوصفها اكبر قوّة غازية، ثقافيّاً واقتصاديّاً وعسكريّاً لهذه القارّة(١) .
وممّن انتحل صفة الاستكشاف والبحث والتنقيب الكاردينال(لا فيجري) (٢) الذي عمل بشكلٍ فاضحٍ وصريح لتكريس الوجود الاستعماري الفرنسي من خلال عمله، وقد أعلن عن ذلك في معرض حديثه عن إفريقيا، وأبدى أسفه الشديد من عدم تمكّنه من نشر النصرانيّة بين المسلمين وخصوصاً الجزائرييّن بقوله: إنّه أراد أنْ يحبّب فرنسا إلى الناس باسم المسيح(٣) .
____________________
(١) محمود، سامي - انتشار الإسلام والدعوة إليه: ٤٣ - ٤٤.
(٢) لا فيجري (١٨٢٥ - ١٨٩٢م) كردينال فرنسي اهتمّ بشؤون الشرق، رئيس أساقفة الجزائر. أُسس جمعيّة الآباء البيض عام ١٨٦٨م. بدأ حياته مبشّراً في شمالي إفريقيا والسودان، كلّفه بذلك البابا بيوس التاسع (١٨٤٦ - ١٨٧٨م) نفسه.
(٣) فروخ، عمر. والخالدي، مصطفى - التبشير والاستعمار: ٢٤٧.
وقد تبلورت وتحدّدت مناطق النفوذ الفرنسي خصوصاً في القارّة الإفريقيّة، وقد بدأت عمليّة الإخضاع العسكري المباشر للنفوذ الفرنسي بالجزائر عام ١٨٣٠م، ثمّ تونس عام ١٨٨١م، ودخلوا السنغال عام ١٨٥١م، إمّا بنين (داهومي سابقاً) فقد احتلّتها فرنسا عام ١٨٩٤م، ومنذ عام ١٨٥٤م خاض الاستكبار الفرنسي من خلال السنغال عدّة محاولات لاحتلال موريتانيا حتّى تمّ له احتلالها في عام ١٩٠٣م، أمّا احتلال بلاد الشام (سوريا ولبنان) فقد تمّ في مطلع هذا القرن(١) .
كما امتدّ النفوذ الفرنسي وثبّت أقدامه في مسقط وزنجبار عام ١٨٨٤ م عندما عقدت فرنسا معاهدة مع سعيد بن سلطان، حاكم هاتين المنطقتين، كما حصلت في عام ١٨٩٩م على تنازل من سلطان مسقط، تحصل بموجبه على مستودع للوقود بطريقة الإيجار في ميناء الجصة(٢) ، وقد نافس الفرنسيّون الانجليز على شبه القارّة الهنديّة واشتبكوا معهم في صراع اقتصادي سياسي عنيف حتّى اضطروا لتأسيس شركة الهند الشرقيّة الفرنسيّة في (بندر عباس) في نفس العام في مقابل شركة الهند الشرقيّة البريطانيّة(٣) .
على ضوء مقرّرات مؤتمر برلين الذي انعقد في عام ١٨٧٨ م والتي وضعت أُسُس هذا النفوذ وحاولت أنْ تخفّف من أسباب الصراع بين الدول الأُوربيّة، وخصوصاً بين فرنسا وانجلترا حول القارة الإفريقيّة(٤) .
وبعد وضوح حدود النفوذ الفرنسي في إفريقيا بدأت حركة واسعة لإخضاع شعوبها إلى الثقافة الفرنسيّة، وبشتّى الصيّغ والأساليب. ففي عام ١٨٩٨م كتب الباباليّون الثالث عشر إلى الكاردينال(لانجينو) ما يلي: (لقد علمنا برضا
____________________
(١) انتشار الإسلام والدعوة إليه: ٤٠ - ٤٩ والخطابي وجمهوريّة الريف.
(٢) السياسة الفرنسيّة في الشرق الأوسط/ المركز الإسلامي للأبحاث السياسيّة: ٣٦١.
(٣) الخطيب، مصطفى عقيل إسحاق - التنافس الدولي في الخليج، السياسة الفرنسيّة: ٣٨٤.
(٤) للمؤلّف - السياسة الفرنسيّة في الشرق الأوسط: ٨٢.
كامل... بأنْ تفكير شخصيّات بارزة يتّجه نحو تكوين لجنة وطنيّة في فرنسا للحفاظ على الحماية الفرنسيّة في الأراضي المقدّسة والدفاع عنها... فعسى أنْ تضمن هذه الجهود المتّحدة وجوداً مستقرّاً للكنيسة الكاثوليكيّة في الشرق؛ لكي تعمل بنجاح على نشر الإيمان الحقيقي ولعودة الرعايا الضالّين إلى حضيرة المراعي الكنسي الأوحد والأعلى)(١) .
صيغ وأساليب المدرسة الاستشراقيّة الفرنسيّة وتشكيلاتها
إنّ من أبرز وأهمّ الأساليب والتشكيلات التي اعتمدتها هذه المدرسة في عملها الاستشراقي، والتي أثّرت في النتائج أثراً بليغاً حقّق أغلب الأهداف والمرامي المتوخّاة منه هي:
أ - تسخير المبشّرين والأقليّات النصرانيّة واليهوديّة المتواجدة في البلدان الإسلاميّة؛ لتجميع المعلومات الأوليّة والدراسات الميدانيّة عن الإسلام والمسلمين في بلدانهم؛ لتكون مادّةً أوليّةً بين يدَي المستشرقين لينطلقوا منها ويتابعوا تفصيلاتها، ويُخضعوها للبحث والتحليل ضمن الخطط الموضوعة لذلك من قِبلهم، وقد تمّ ربط النصارى من مواطني البلدان بالتشكيلات التي اعتمدتها فرنسا عن طريق الحصول على امتيازات خاصّة، بحجّة (حماية المسيحيّين في الإمبراطوريّة العثمانيّة).
ويشير إلى ذلك G. Bouchad أحد مسؤولي البعثات الفرنسيّة حيثُ قال: (... في هذا القرن [القرن التاسع عشر] دخلت أوربّا في عصرٍ جديد من
____________________
(١) مجلّة المنتقى - العدد الأوّل: ٦٧ ابريل ١٩٨٣م.
التوسّع العسكري والسياسي، بدأ مع الثورة الصناعيّة التي قلبت الأوضاع الاجتماعيّة والفكريَّة داخل أوربّا، وأدّت إلى ولادة الرأسماليّة، وخروج أوربّا من حدودها لمواجهة الكتلة الإسلاميّة الضخمة، المتمثّلة في (الإمبراطوريّة العثمانيّة) المترامية الأطراف، وكانت الامتيازات التي حصلت عليها دول أوربّا (لحماية المسيحيّين) داخل (الإمبراطوريّة) حجّةً وجسراً، عبرت عليه البعثات المختلفة إلى الطوائف المسيحيّة والأقليّات الدينيّة، تحميها شرعيّة القنصليّات والسفارات، أو القوّة العسكريّة المباشرة، فأسّست مدارسها الخاصّة بها، وأرست أُسس نظام تعليمي يستلهم الثقافة الأوربيّة ويبشّر بها)(١) .
ولم يكتفوا بذلك بل أخذوا بإعداد وتربية مبشّرين محلّيّين، من خلال مدارس(اكليركيّة) يتخرّج منها ما يسمّى بالاكليروس المحلّي، خصوصاً وأنّ عامل اللغة يعدّ أساساً في أداء الدور الأمثل لهؤلاء المبشّرين المحلّيّين، وفي هذا الصدد يركّز مؤرّخو تلك الفترة: إنّ اليسوعيّين لجأوا بعد سنوات من العمل المتواصل والدؤوب إلى إعداد (الدعاة المحلّيّين)، أملاً في تثبيت مستقبل العمل التبشيري في المشرق، وسعياً لتجاوز عائق اللغة الذي كان يُقلق مرسليهم ويُعرقل صلتهم اليوميّة بالذين يتوجّهون إليهم؛ لأن المبشّرين لا يعرفون العربيّة لغة السكّان في هذه المناطق.
هذه الحاجة الماسّة والمتناهية لهؤلاء (الدعاة) يُعبّر عنها أحدُ الآباء المسؤولين في دمشق عام ١٨٦٠م بقوله:
لا(اكليروس) محلّي بدون مدرسة(الكليركيّة) ، ولا مستقبل للإرساليّات في المشرق في غياب(الأكليروس) المحلّي. إنّ إرسال البعثات مفيد ولا شك، خاصّة وسط هذه الأُمم الجاهلة والكسولة، لكنّ المؤسّسة الأوربيّة ليست مؤسّسة صلبة
____________________
(١) الدكتور عتريسي، طلال - البعثات اليسوعيّة: ٢٤.
بشكلٍ كاف؛ لأن جذورها لا توجد في البلد نفسه... والسبب الذي يدعونا لتكوين(اكليروس) محلّي هو عينه الذي يدفعنا لإعداد أساتذة محلّيّين أيضاً.. إنّ المعلّم والمعلّمة العربيّين يستطيعان الذهاب، وكلٌّ بمفرده، إلى أيّة قرية، فهما متكيّفان مع اللغة والمناخ والعادات والغذاء مع بؤس البلد، كما يكفي الواحد منهما مئة فرنك في السنة(١) .
لذا وتثبيتاً لمستقبل هذه الإرساليّات، ضمّ اليسوعيّون مساعدين لهم من أهل البلاد، بعد اختيارهم بدقّة وعناية؛ لأن بإمكانهم ممارسة نفوذ وتأثير يعجز عنه الأجانب غالباً.
(لقد كان ذلك تطبيقاً للقاعدة الحكيمة التي طالما نادى بها البابا ليون الثالث عشر، وهي إغواء الشرق بواسطة الشرقيّين أنفسهم)(٢) .
واتّسعت فكرة استثمار النصارى والأقليّات المذهبيّة الأُخرى من أبناء الشرق لتشمل اليهود، خصوصاً في بعض المناطق التي كانت لهم فيها طموحات دينيّة وتاريخيّة كفلسطين، حيثُ ذهب بعضهم إلى: (إنّ المبشّرين كانوا مقتنعين جداً، بأنّ جمع اليهود في فلسطين يُسهّل لهم مهمّتهم في الوصول إلى المسلمين، من أجل ذلك أرادوا أنْ يفتحوا أبواب فلسطين على مصاريعها لهجرة اليهود)(٣) .
(فليس من المستغرب إذن أنْ تجد سبعاً وعشرين جمعيّة تبشيريّة مختلفة الجنسيّات كانت تعمل بلا مَلل في فلسطين)(٤) .
ب - اعتماد أُسلوب ضخ اكبر عدد من المستشرقين الفرنسيّين من ذوي
____________________
(١) شقالييه، مجمع جبل عامل: ٢٦٧.
(٢) Bullet In Doeuvres Des Ecoles Dorient ١٨٦٢: ٢١٠ – ٢١٢.
(٤) Richter ٢٣٨.
الاختصاصات التبشيريّة إلى بلدان الشرق الإسلامي.
لقد أعدّت فرنسا جيشاً من المبشّرين والمستشرقين الذي ينتشرون في إفريقيا ولبنان، ويذكر مالك بن نبي: (أنّ المستشرق الفرنسي(ماسنيون) قد تفرّغ آخر حياته للتبشير، ومدّ وزارة الخارجيّة الفرنسيّة بالمعلومات والتوصيّات حول البلاد الإسلاميّة وتهيئة العملاء والكتاب)(١) .
ويكفي أنْ نشير إلى الرقم الآتي ليعبّر عن مدى العمق الرابط الوثيق، بين الصليبيّة والرهبانيّة الفرنسيّة وبين الاستشراق والاستكبار، فقبل الحرب العالميّة الأولى بلغ عدد المبشّرين المرتبطين بالمقام البابوي ٧٣٠٠٠ مبشّراً، كان ثلاثة أرباع هؤلاء من التابعيّة الفرنسيّة الذين توجّهوا إلى سوريا في مجال التعليم.
أمّا (مؤسّسة الدّعاية)، وهي منظمة صليبيّة تبشيريّة فرنسيّة، فقد أصدرت عام ١٨٨٨م هذا التعميم: (إنّنا نعلم بأنّ الحماية الفرنسيّة قائمة في المشرق مُنذ عدّة قرون، ولقد تأكّدت هذه الحماية من خلال المعاهدات الموقّعة بين الحكومات، لذلك يجب أنْ لا يتمّ أيّ تغيير على الإطلاق بخصوص هذه النقطة.
يجب الحفاظ دينيّاً على هذه الحماية أينما كانت سارية، كما يجب أنْ تعلم البعثات التبشيريّة بأنْ تلجأ عند الحاجة - لأيّ عَون - إلى قناصل وممثّلي الأمّة الفرنسيّة)(٢) .
ج - توجيه المبشّرين الفرنسيّين للتخصّص في الاستشراق، ورسم مناهجه بما يخدم الأهداف الثقافيّة والسياسيّة للاستكبار الفرنسي.
فقد تلبّس المبشّرون بجميع المظاهر، حتّى في ثوب المستكشفين الذين ظهروا أمام العالم، علماءً أعلاماً، بل إنّ نابليون حوّر وطوّر من أساليب الاحتواء
____________________
(١) د. الخالدي، مصطفى، د. فروخ، عمر - التبشير والاستعمار: ٢٢١.
(٢) مجلّة المنتقى - ع١: ٦٨ ابريل ١٩٨٣م.
الاستشراقي لمصر قبل وبعد احتلالها باستخدام أدوات المعرفة والقوّة الغربيّتين، ومنذ ذلك التاريخ تغيّرت لغة الاستشراق ذاتها تغيّراً جذريّاً، فقد ارتقت واقعيّتها الوصفيّة وغدت لا مجرّد أُسلوب للتمثيل، بل لغة، بل بالأحرى وسيلة للخلق(١) .
لقد أصبح المستشرقون، خلال القرنَين التاسع عشر والعشرين، جماعة أكثر جدّية؛ لأنّ أبعاد الجغرافيا التخليليّة والواقعيّة كانت بهذا الوقت قد تقلّصت، إذ إنّ العلاقة الشرقيّة الأوربيّة كانت قد تحدّدت بتوسّع أوربّي لا يُصدّ، بحثاً عن الأسواق والمصادر الطبيعيّة والمستعمرات.
وأخيراً لأنّ الاستشراق كان قد أنجز تقمُّصَه وتحوّله من إنشاء بحثيّ إلى مؤسّسة إمبرياليّة(٢) .
ولقد أصبحت باريس فترة تنوف على النصف الأوّل من القرن التاسع عشر عاصمة للاستشراق (وعاصمة القرن التاسع عشر نفسه، كما يرىفالتر بنجمن )(٣) .
وتكفي للإحاطة بهذه الحقيقة المراجعة لكتاب جُول مول (سبعة وعشرون عاماً من تاريخ الدراسات الشرقيّة)(٤) .
د - خلِق أرضيّة الارتباط الروحي والمعنوي بفرنسا، والعمل على تشويه الثقافة الإسلاميّة، وإثارة الشبهات حول الإسلام والحركات الإسلاميّة، باعتبارها عقَبة أساسيّة أمام ترسيخ اتّجاهات الفكر الاستكباري. وهذا ما يؤكّده المتخصّصون في دراسة الاستشراق، فعند المقارنة والتمييز بين المدرسة الاستشراقيّة الفرنسيّة والمدرسة الاستشراقيّة البريطانيّة مثلاً يقولون: (... في
____________________
(١) سعيد، ادوارد - الاستشراق: ٥١، ١١٢.
(٢) سعيد، ادوارد - الاستشراق: ١٢٠.
(٣) سعيد، ادوارد - الاستشراق: ٨٢.
(٤) وهو سجل في مجلّدين لكلّ ما له قيمة من أحداث في الاستشراق بين ١٨٤٠م - ١٨٦٧م، وقد كان مول هذا أميناً للجمعيّة الآسيويّة في باريس.
عرف بريس - موريس بريس مؤلّف كتاب (اكتناه بلدان شرق المتوسّط)، وهو سجل لرحلة عبر الشرق الأدنى عام ١٩١٤م - إنّ الحضور الفرنسي يُرى بأفضل صورة في المدارس الفرنسيّة... وإذا كانت فرنسا لا تمتلك مستعمرات في الشرق فعليّاً، فإنّها ليست دون ممتلكات بصورة مطلقة... ثمّة في الشرق شعور حول فرنسا هو من الدينيّة والقوّة بحيث إنّه قادر على أنْ يتمثّل، ويُصالح بين تطلّعاتنا الأكثر اختلافاً وتنوعاً.
ففي الشرق نمثّل نحن الروحانيّة، والعدالة، وفُصْلَةَ المثالي... نحن نمتلك الأرواح الشرقيّة... كيف نستطيع أنْ نشكّل لأنفسنا نخبة فكريّة نقدر على العمل معها، تتألّف من شرقيّين لنْ يكونوا قد اقتلعوا من جذورهم، شرقيّين يستمرّون في الارتقاء تبعاً بيننا وبين جماهير السكّان الأصليّين؟ كيف سنخلق علاقات بهدف تمهيد الطريق لاتّفاقيّات ومعاهدات، ستكون هي الشكل المرغوب فيه لمستقبلنا السياسي (في الشرق)؟ هذه الأشياء جميعاً في النهاية ذات مدار واحد، هو تنمية ذوق استمراء لدى هذه الشعوب الغربيّة للبقاء على اتّصال بذكائنا، رغم أنّ هذا الذوق قد ينبع في الواقع من حسّهم الخاص بمصيرهم القومي)(١) .
ويؤكّد هذه الميزة أيضاً منهج السياسة الفرنسيّة في التعامل مع الشرق التي تتمثّل بمقولة: (إذا كان لفرنسا أنْ تستمرّ في منع (عودة الإسلام)، فقد كان من الخير لها أنْ تحتلَّ الشرق، وكانت هذه منظومة طرَحها كريساني وثنّى عليها السيناتور بول دومر. وقد كُرِّرت هذه الآراء في مناسباتٍ كثيرة، وبالفعل فقد نجحت فرنسا بمفردها في شمال افريقيا بعد الحرب العالميّة الأُولى)(٢) .
____________________
(١) سعيد، إدوارد - الاستشراق: ٢٥١.
(٢) سعيد، إدوارد - الاستشراق: ٢٣٤.
ويحذّر الكاردينال(لافيجيري) من خطر قوّة الإسلام وتهديدها للتطلّعات الفرنسيّة في الشرق فيقول: (وبينما كان الإسلام على وشك أنْ ينهار في أوربّا مع عرض السلاطين (من آل عثمان)، كان لا يزال ناشطاً في تقدّمه وفتوحه على أبواب مملكتنا الإفريقيّة)(١) .
ولا يجد هؤلاء مناصاً من الإمعان في تشويه الإسلام تحقيقاً للهدف الأساسي، في إضعاف قوّته وردم سدوده أمام غزوهم الثقافي واستعمارهم السياسي والعسكري، حتّى وصل بهم الأمر إلى أنْ يقول أحدهم: (إنّ الإسلام مقلّد، وإنّ أحسن ما فيه مأخوذ من النصرانيّة، وسائر ما فيه أُخذ من الوثنيّة كما هو، أو مع شيء من التبديل)(٢) ، ويبلغ التدجيل ذروته(بجون ثاكلي) أنْ يقول عن المسلمين: (يجب أنْ نستخدم كتابهم [أيّ القرآن الكريم]، وهو أقصى سلاح في الإسلام، ضدّ الإسلام نفسه لنقضي عليه تماماً.
يجب أنْ نُري هؤلاء الناس أنّ الصحيح في القرآن ليس جديداً، وأنّ الجديد فيه ليس صحيحاً)(٣) .
وفي معرض إثارتهم للشبهات حول الحركات الإسلاميّة كتب(يوليوس رشتر) عن(ثورة المهدي على الانجليز) في السودان قائلاً في وصفها: (... هذا التعصّب الإسلامي الضيّق الأُفق بكلّ ما فيه من بُغض للثقافة)(٤) .
هـ - الدعوة إلى تطوير الإسلام كأُسلوب للدس فيه وتشويه معالمه. فمن انجازات المستشرقين الكبيرة - وفي مقدّمتهم المستشرقون الفرنسيّون - إنّهم أثاروا في قلوب قادة العالم الإسلامي اليوم وزعمائه - ممّن تثقّفوا في مراكز الغرب
____________________
(١) pottier ١١٣.
(٢) Islam And Missions ٤٣.
(٣) Islam And Missions ٢١٧ f
(٤) Julius Richter ٣٦٦.
الثقافيّة الكبرى أو درسوا الإسلام بلغات الغرب - شُبهات حول الإسلام والمصادر الإسلاميّة، وأحدثوا في نفوسهم بأساً كبيراً في الحثّ على نعرة (إصلاح الديانة) و(إصلاح القانون الإسلامي)(١) .
ومن أبرز هؤلاء المستشرقين الذين بذلوا عناية خاصّة بهذه الدعوة هو المستشرق الفرنسي(ماسينيون) ، فقد كان له حضور رئيسي في العلاقات الإسلاميّة الفرنسيّة، في السياسة كما في الثقافة، وكان بوضوح رجلاً ذا شبوب انفعالي.
آمن بأنّ عالم الإسلام يُمكن اختراقه لا عن طريق البحث، حصريّاً، بل عن طريق تكريس النفس لجميع أوجه نشاطاته، التي لم يكن أقلّها عالم المسيحيّة الشرقيّة المنضوية ضمن الإسلام، والتي تلقّت إحدى جماعاتها الفرعيّة، الجمعيّة الخيريّة البدليّة، تشجيعاً حارّاً من قِبل ماسنيون(٢) .
ويؤكّد هذه الدعوة، التي أخذت اتّجاهاً عاماً في أغلب الدراسات الاستشراقيّة، التركيز والاهتمام الشديد الذي أولاه المستشرقون الفرنسيّون بالدراسات الإسلاميّة، وهذا نابع من روحهم الصليبيّة وغرضهم الرئيسي، وهو تحديد نقاط ضعف المسلمين ومحاولاتهم فهم الإسلام؛ لكي ينفذوا إلى المجتمع الإسلامي عن طريق ذلك، ولهذا تجد أنّ(كريساني) ومن بعده السيناتور(پول دومر) قد طرحا منظومة مفادها أنّ من الخير لفرنسا إذ كانت مستمرّة في منع عودة الإسلام أنْ تحتلَّ الشرق.
وقد كرّر هذان المستشرقان هذه الآراء في مناسبات كثيرة، وبالفعل فقد نجحت فرنسا بمفردها في شمال إفريقيا وسوريا بعد الحرب العالميّة الأولى(٣) .
____________________
(١) الصراع بين الفكرة الإسلاميّة والفكرة الغربيّة: ١٧٨.
(٢) سعيد، إدوارد - الاستشراق: ٢٧٠.
(٣) سعيد، إدوارد - الاستشراق: ٢٣٤.
و - توقيت حركة المستشرقين الفرنسيّين وتغلغلهم في البلاد الإسلاميّة، بما يمهّد لمقدّمات الغزو الفرنسي لهذه البلدان، وتحكيم السياسة الفرنسيّة منها، ومن الأرقام الكاشفة عن هذه الحقيقة أنّ عدداً كبيراً مِن مترجمي نابليون كانوا تلاميذ (سلفستر دوساسي)، الذي كان - بِدءاً من حزيران عام ١٧٩٦م - المدرّس الأوّل والأوحد للعربيّة في المدرسة الأهليّة للّغات الشرقيّة.
وأصبح ساسي فيما بعد تقريباً معلّماً لكلّ مستشرق بارز في أوربّا، حيث سيطر تلاميذه على هذا الحقل ما يُقارب ثلاثة أرباع القرن، وكان كثيرون منهم نافعين سياسيّاً، بالطُرق التي كان بها عدد آخر نافعاً لنابليون في مصر(١) .
بل إنّ دور المستشرقين أخذ مدىً أكبر من ذلك عندما أصبح التنافس الاستكباري يدفع بالمستكبرين، إلى إدخال دول الشرق بمنظورهم الاستعماري في مجال الاستشراق، فقد (كان قدرٌ كبير من الحمى التوسّعيّة في فرنسا خلال الثلث الأخير من القرن التاسع عشر، وليد رغبةٍ صريحة للتعويض عن النصر البروسي في ١٨٧٠م - ١٨٧١م، وإلى حدٍ لا يقلّ أهميّة وليد رغبةٍ لمضاهاة الانجازات الامبرياليّة البريطانيّة.
ولقد كانت الرغبة الأخيرة من القوّة، كما كانت نابعة من تراثٍ طويل من المنافسة الانكلو - فرنسيّة في الشرق، بحيث إنّ فرنسا بدت حرفيّاً مشبوحةً ببريطانيّا، حريصة في كلّ ما يتعلّق بالشرق على اللّحاق بالبريطانيّين ومحاكاتهم.
وحين صاغت الجمعيّة للهند الصينيّة في أواخر عام ١٨٧٠م أهدافها، وجدت مهمّاً أنْ (تدخل الهند الصينيّة في مجال الاستشراق) لماذا؟ من أجل أنْ تُحيل صين كوشين إلى (هندٍ فرنسيّة)!
وقد عزا العسكريّون إلى عدم وجود مُمتلكات استعماريّة كبيرة لفرنسا،
____________________
(١) سعيد، إدوارد - الاستشراق: ١٠٩.
ذلك المزيجَ من الضعف العسكري والتجاري إثناء الحرب ضدّ بروسيا، كي لا تقول شيئاً عن الشعور العريق والصريح بالنقص، استعماريّاً، بالمقارنة مع بريطانيا.
وقد طرح جغرافي بارز هو (لا رونسيير لو نوري) منظومةً تقول: إنّ قوّة توسّع العروق الأوربيّة وأسبابه وعناصره وتأثيراته على المصائر البشريّة، ستشكّل مادّة دراسة جميلة للمؤرّخين في المستقبل)(١) .
ولهذا تجد أنّ (أكثر الإرساليّات مساهمةً في تحقيق انتداب فرنسا على سوريا ولبنان هي الإرساليّات الفرنسيّة)، (لأنّ من بين الاثني عشر ألفاً من طلاّبهم، كما يقول الأب(لوروا) : سبعةٌ كانوا وزراء أو سكرتيري دولة في مصر.. وأنّ مدراء الخدمات الرسميّة في لبنان وسوريا، وفي دولة العلويّين آنذاك كانوا جميعاً من طلاّب العازاريّين)(٢) .
كما (لم تحمل البعثات الفرنسيّة والتبشيريّة التي توافدت إلى سوريا ولبنان مشاريعَ مستقلّة عن السياسة الفرنسيّة فيها، إنّما اقتصر أمر التمايز والاختلاف على المرحلة الأولى من عمل اليسوعيّين، التي احتلّت موقع الصدارة بين البعثات جميعاً)(٣) .
والطريف المثير ذكره هنا أنّه: (في الحرب العالميّة الأولى ترك المبشّرون عملهم التبشيري، وجعلوا يطوفون في المناطق ويجمعون المتطوّعين لجيوش دولهم)(٤) .
ز - استعانة المستشرقين الفرنسيّين، ضمن برامج المؤسّسات السياسيّة الفرنسيّة، بالأقليّات النصرانيّة واليهوديّة وأمثالها القاطنة في البلدان الإسلاميّة، كمصدر للمعلومات الميدانيّة والرؤى المباشرة للواقع، وكسندٍ سياسي واقتصادي
____________________
(١) Agnes Murphy, The Ideology of French Imperialism ١٨١٧ – ١٨٨١ (Washington: Catholic University of America Press, ١٩٤٨) pp. ٤٦ , ٥٤ , ٣٦ , ٤٥.
(٢) Revue Dhistorie Des Missions. P ٥٢٢.
(٣) الدكتور عتريسي، طلال - البعثات اليسوعيّة: ١٦١.
(٤) الدكتور خالدي، مصطفى والدكتور فروخ، عمر - التبشير والاستعمار في البلاد العربيّة: ٢٤٤.
بل وعسكري للاستعمار الفرنسي، ويميط اللثام عن هذا الأمر ما أشار إليه كتاب السياسة الدوليّة في الشرق العربي، حيثُ جاء فيه: (كانت بلاد الشام محطّة نموذجيّة لنشاط البعثات، وأطماع الدول الأوربيّة وتنافسها)(١) ولانتشار المدارس التي رافقت عمل المبشّرين، بحيث تحوّلت الخصوصيّات الاجتماعيّة والطائفيّة إلى صراعات وولاءات ثقافيّة وسياسيّة، تحتضنها الإرساليّات ويدعمها القناصل والتجّار.
وتحوّل الهدف الأساسي لتعليم المرسلين، بعد أنْ تداخل مع السياسة والتجارة، إلى إعداد (لعقول) تتلاءم مع الأوضاع الجديدة، و(نخب) ستتربّع على رأس كيانات التجزئة التي فُرِضت قسراً.
وكان لجبل لبنان، قبل أنْ تلحق به أقضية ومناطق في سوريا، ويتحوّل إلى (دولة لبنان الكبيرة) عام ١٩٢٠م، وبعد ذلك أيضاً؛ حصّة وفيرة من نشاط البعثات وأهدافها، لا بل نقطة جذب قويّة لها بسببِ كاثوليكيّتها من جهة، والحضور الفرنسي السياسي والعسكري والاقتصادي من جهةٍ أُخرى، وهي عوامل أدّت إلى إلحاق سكّان الجبل المسيحيّين بفرنسا على جميع المستويات(٢) .
وفي أجواء هذه التحوّلات الاقتصاديّة السياسيّة، والتدخل في شؤون الطوائف المحليّة، انتشرت بعثات التبشير والتعليم اليسوعيّة؛ لتجعل لتلك التحوّلات ولذلك التدخّل أُسُساً فكريّة (وجذوراً تاريخيّة)، (ففتحت نفوس الأهالي على الأفكار الفرنسيّة، وعلى العواطف الفرنسيّة، وأصبحوا فرنسيّين نوعاً ما... هذه السياسة تؤدّي إلى فتح بلدٍ بواسطة اللغة)(٣) .
____________________
(١) راجع إسماعيل عادل - السياسة الدوليّة في الشرق العربي ٤: ١١٣ - ١١٦.
(٢) الدكتور عتريسي - البعثات اليسوعيّة: ٢٧.
(٣) Paul Huvelin – Conger,s francais surga Syrie – Fascicule ١١١ Champe De Commeree Marseille ١٩١٩ – p. ٧. ٨.
وهكذا حتّى أصبح الموارنة، مثلاً، في منتصف القرن التاسع عشر مركزاً لتلقى التأثيرات الثقافيّة والاقتصاديّة والسياسيّة الفرنسيّة. خاصّةً وأنّ فرنسا أصبحت صاحبة (الحق) في (حماية مسيحيّي الشرق)، فتداخل آنذاك هذا الموقع المتقدّم لفرنسا، قياساً إلى الدول الأوربيّة الأخرى، مع علاقاتها التاريخيّة مع الموارنة التي يُعرب كلّ طرفٍ عن شدّة تمسّكه بها وفقاً للظروف السياسيّة والدوليّة(١) .
وتختلف الروايات التاريخيّة في تحديد هذه العلاقة، ما بين الدعم العسركي المتبادل، أو الحماية المعنويّة، فيقول بوديكور مثلاً: (عندما انطلق ملكَنا(سان لويس) في حربه الصليبيّة، توقّف في قبرص حيثُ لاقاهُ دعم ٣٥ ألف ماروني خاض معهم معركة مصر..)(٢) ، (كما أرسل إليهم بونابرت مبعوثه قائلاً لهم: (أعترف أنّ الموارنة فرنسيّين مُنذ الأزل)(٣) .
ووجّه ملك فرنسا إلى أمير الموارنة الرسالة التالية: (.. نحن مقتنعين بأنّ هذه الأمّة التي تنتسب إلى القدّيس مارون هي جزء من الأُمّة الفرنسيّة)(٤) . كما كتب وزير البحريّة الفرنسيّة عام ١٧٥٠م إلى القناصل الفرنسيّين في الدولة العثمانيّة: (إنّ الرهبان الموارنة الذين يؤلّفون رهبنة(مارانطونيوس) في جبل لبنان، قد شملهم الملك بحمايته الخاصّة في كلّ وقت، وقد توسّطوا إلى جلالته أنْ يُجدّد تلك الحماية ويثبّتها لهم، فتنازل جلالته واستجاب طلبهم وأوصاني أنْ أكتب إليكم، أنْ تعاملوهم كما تعاملون المُرسلين الفرنسيّين، الموجودين في الشرق من قِبل جلالته..)(٥) .
____________________
(١) الدكتور عتريسي، طلال - البعثات اليسوعيّة: ٤٩.
(٢) Baudicour. Louis De: Le France en syrie – paris ١٨٦٠ – p. ٦.
(٣) Rochementeix C.P.J: Leban Et I ex pedition Frandcaise En Syrie ١٨٦٠ – ١٨٦١ Documents Inedits Du General A. Ducroit Paris ١٩٢١ – p. ٧٩.
(٤) المصدر السابق، عتريسي: ٧٠.
(٥) الخورس بطرس غالي - (فرنسا صديقة ومحامية): ٣٢٦ - ٣٢٧. ذكره الكوثراني: ٤٤.
وتزداد هذه الحقيقة وضوحاً إذا عرفنا (إنّ فرنسا تعتبر نفسها مسؤولةً عن حماية مسيحيّي المشرق أمام الباب العالي، وإنّ هذه المسؤوليّة تشكّل دعماً أساسيّاً لقوّتها في المشرق، ولا يُمكن لرجال الدين الذين تُرسلهم روما، أنْ يتجاوزوا هذه الحماية القانونيّة والعمليّة)(١) .
ولم يقتصر الأمر على الطوائف المسيحيّة، بل استُخدم اليهود في الشرق كرَتل خامس، ورجال المعلومات الخاصّة. فمثلاً (عندما قامت الثورة الفرنسيّة، التي لعبت اليهوديّة الفرنسيّة فيها دوراً خطيراً، قامت اليهوديّة العالميّة بخدمات جليلة لحساب نابليون بونابرت، حيث تحوّل اليهود في أوربّا وفي الشرق العربي إلى طابورٍ خامس يعمل لحساب جيوش بونابرت، وتقديراً لتلك الخدمات التي تبلغ مرتبة الخيانة العُظمى لشعوب دول روسيا القيصريّة، أعلن نابليون هيئة السنهدريون، وكوّن فرقة من اليهود لإعادتهم إلى فلسطين، إلاّ أنّ المشروع لم يتحقّق لظروفٍ لم تكن مواتية)(٢) .
ح - توصية المستشرقين الفرنسيّين لحكوماتهم المتعاقبة، على اعتماد أُسلوب التجزئة للبلاد الإسلاميّة، وتدمير البُنى الأساسيّة لها ثقافيّاً واجتماعيّاً واقتصاديّاً، وتركهم ضعفاء لا يملكون القدرة على مواجهة تيار العلمانيّة الفرنسيّة الجديد.
ولعلّ من أبرز من كان لهم الدور الأساسي في تنظير هذه التوصيات، هو(ماسنيون) أحد أكبر أئمّة المدرسة الاستشراقيّة الفرنسيّة، خصوصاً عندما أصبح مستشاراً لوزارة المستعمرات الفرنسيّة، وتدلّنا الوثائق العديدة التي نشرت وما زالت تُنشر أنّ فرنسا قبل وبعد دخولها إلى الشام، قد قامت من خلال الاستعانة بالمستشرقين وتوصياتهم بعدّة دراسات عن الوضع الاجتماعي والطائفي
____________________
(١) شقالييه دومينيك، مجتمع جبل لبنان: ٢٦١.
(٢) السعدين، مصطفى - أضواء على الصهيونيّة: ١٠.
والاقتصادي.. وإنّها قد صمّمت سياسةً فرنسيّةً خاصّةً بها، تقوم على تصوّرات دقيقة ومتعدّدة، منها ما يخصّ تصميم البنية السياسيّة، وبناء الدولة وإقامة الأنظمة الطائفيّة، أو تسليط طبقة من النصارى على المؤسّسات السياسيّة والثقافيّة والاقتصاديّة الحسّاسة.. وهذه كلّها تهدف إلى نقطةٍ جوهريّةٍ وأساسيّة، هي: ضمان إبعاد الإسلام عن مسرح الحياة، والنشاط السياسي والثقافي، وخلق أنظمة علمانيّة، وإعداد الكوادر والقيادات السياسيّة المواكبة لها(١) .
كما جاء أيضاً في تقرير(ديبوسك) إلى وزارة الخارجيّة الفرنسيّة: (لقد تسنّى لي في القاهرة وبيروت ودمشق أنْ أطّلع على الآراء الحميمة، التي باح لي بها بعض المسلمين الذين يحتلّون مراكز مرموقة، فلقد صرّح لي هؤلاء ببساطة: أنّ الوفاق مع المسيحيّين يبدو في نظرهم ضروريّاً؛ لأنّ المسيحيّين هم أذكي منهم، وخصوصاً أكثر ثقافةً منهم، وبالتالي فهم أجدر في إظهار مطالباتهم الخاصّة.
ومن جهتهم فلقد صرّح لي مسيحيّون أعضاء في المجالس - يقصد مجالس اللجان العربيّة - بأنّهم لا يرتجون عن طريق انضمامهم إلى صفوف المسلمين سوى تدخّل فرنسا، وفضلاً عن ذلك فأنّهم - أيّ المسيحيّين - خلافاً لما يعتقده المسلمون، يرون أنّه ليس بإمكان سوريا أنْ تحكم نفسها بنفسها، إلاّ أنّهم يتجنّبون مواجهة المسلمين بذلك)(٢) .
وبنفس الاتّجاه يوصي القسسيمون حكومته الفرنسيّة قائلاً: (إنّ الوحدة الإسلاميّة تجمع آمال الشعوب السمْر وتساعدهم على التخلّص من السيطرة الأوربيّة).. ولذا (قالوا: يجب أنْ تحوَّل بالتبشير مجاري التفكير في الوحدة الإسلاميّة)(٣) .
____________________
(١) للمؤلّف - السياسة الفرنسيّة في الشرق الأوسط: ١١٠.
(٢) الكوثراني، وجيه - بلاد الشام: ٣١٦.
(٣) الدكتور خالدي، مصطفى والدكتور فروخ، عمر - التبشير والاستعمار في البلاد العربيّة: ٣٧.
وعلى ضوء ذلك فقد قام الاستعمار الفرنسي بإنشاء كيانات مُجزّأة سياسيّاً واقتصاديّاً وسكّانيّاً، وفقا للنماذج والأشكال القوميّة الغربيّة والعلمانيّة، وبذلك يتمكّن الاستعمار الفرنسي وشُركاؤه أنْ يطمئنّوا إلى أنّ البلاد الإسلاميّة، أصبحت لا تشكّل خطراً على نفوذهم ومصالحهم حاضراً ولا مستقبلاً، فالمسلم في (تشاد) هو (تشادي) لا علاقة له بما يجري في (المغرب) أو (تونس) لأنّ الآخرين (مغاربة) أو (تونسيون)... وهكذا الأمر في كافّة أنحاء العالم الإسلامي(١) .
ط - اعتماد أُسلوب تربية وإعداد قادة ومفكّرين للعالم الإسلامي، على النهج العلماني من خلال الجامعات الفرنسيّة، التي يشرف عليها كبار رجال الاستشراق الفرنسي، المتميّزين بقدرتهم على الدسّ في الإسلامي وتشويه صورة مجتمعاته الإسلاميّة.
وكان على رأس أساتذة ومنظّري هذه الأُطروحة، هو المشرف الروحي للكنائس المسيحيّة البروتستانتيّة الفرنسيّة لما وراء البحار، والمستشرق الشهيرماسنيون ، الذي تعهّد مجموعة من أنبغ رجال الشرق - كما يصفهم - حتّى قال بشأن أحدهم وهو(ميشيل عفلق) مؤسّس حزب البعث العربي الاشتراكي، الذي ظلّ يلعب دوراً أساسيّاً في قيادة بعض الأنظمة العلمانيّة في الشرق الأوسط، طيلة الفترة بعد الحرب العالميّة الثانيّة: (إنّه أنبغ وأعزّ تلميذ في حياتي)(٢) .
ويتحدّث الباحث الفرنسي دانيال لوغاك في كتابه (باسم فلسطين) عن دور فرنسا أيّام الاحتلال في تنمية ورعاية حزب البعث فيقول: (إنّ ميشيل عفلق، وبدرجةٍ أقلّ من صلاح الدين البيطار (الأبوين المؤسّسين للبعث) مدينان جزئيّاً لفرنسا بتأليف الحزب الأكثر تماسكاً والأكثر تأثيراً في العالم العربي
____________________
(١) للمؤلّف - السياسة الفرنسيّة في الشرق الأوسط: ٧٥.
(٢) بلوط، عليّ - دمشق.. إعدام البعث / مجلّة الدستور اللبنانيّة.
بأسره)(١) .
وكان لابدّ من التمهيد لهذا الأمر عن طريق تشويه صورة الإسلام، في كتب وبرامج التعليم المعتمدة في المدارس والجامعات، المؤسّسة بهدف صياغة وإعداد الكوادر والقادة السياسيّين على الطريقة العلمانيّة الفرنسيّة، فقد جاء في كتاب (البحث عن الدين الحقيقي)، الذي صدر عن مؤسّسات التعليم الفرنسي في باريس، وعاش هذا الكتاب في المدارس النصرانيّة في الشرق والغرب حتّى اليوم: (إنّ الإسلام عدوّ للمسيحيّة وإنّه أُسّس بقوّة السيف، وقام على أشدّ أنواع التعصّب... ويؤكّد هذا الكتاب - أيضاً - أنّ الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قد سمح لأتباعه بالفجور والسلب(٢) .
وقد حملت مؤسّسات اليسوعيّين على تنوّعها، أهدافاً تتكامل فيما بينها، من نشر الثقافة الفرنسيّة، وسيطرة لغتها وأفكارها، إلى إعداد (النخبة القائدة) التي تمثّل الهدف الرئيسي بينها؛ (لأنّ إعداد النخبة المسيحيّة.. يسمح لهذه الجماعة التي أثقل كاهله النيّر الإسلامي، أنْ تتحضّر شيئاً فشيئاً.
وقد أعدّ المرسلون لساعة الحريّة، طبقة وسطى قادرة على انتزاع الفائدة، ونخبة ذكيّة، مثقفّة ومؤهّلة لقيادة الأُمم المحرّرة.. غنّه لواجب على المرسلين أنْ يُطوّروا النخبة الأهليّة ويضاعفوها، وذلك بانتظار اليوم الذي ستترك فيه سوريا ولبنان، لكن هناك شيء يجب الانتباه والإشارة إليه، ذلك: إنّ النخبة لا تبقى كذلك إلاّ إذا سيطرت، وإذا أردنا توسيع هذه النخبة، فيجب ألاّ نخفض مستواها بأنْ نفتح المجال أمام الجميع لتولّي المراكز والمسؤوليّات، وذلك تفادياً للإخلال بالتوازن والانسجام الاجتماعي في
____________________
(١) دانيال لوغاك - باسم فلسطين/ إصدار البعث العربي الاشتراكي - سلسلة الدراسات السياسيّة: ٦٤.
(٢) الدكتور خالدي، مصطفى والدكتور فروخ، عمر - التبشير والاستعمار في البلاد العربيّة: ٧٢.
البلد)(١) .
ويرى بعضهم أنّ (المدارس قوّةٌ لجعل الناشئين تحت تأثير التعليم المسيحي أكثر من كلّ قوّةٍ أُخرى، ثمّ إنّ هذه التأثير يستمر حتّى يشمل أولئك الذين سيصبحون يوماً ما قادة في أوطانهم)(٢) ، ويؤكّد آخرون على أنّه (كان للمبشّرين غاية من التعليم العالي، هي أنْ يؤثّروا في قادة الرأي في البلاد، وفي الجيل الناشئ في الشرق الأدنى خاصّة، ذلك التأثير الذي لا يمكن أنْ يتحقّق إذا لم يكن ثمّة تعليم عال)(٣) .
وعلى هذا الأساس أوجد المبشّرون البروتستانت كليّة في بيروت عام ١٨٦٢م ن وجعلوا على رأسها المحترم (دانيال بلس).
هذه الكليّة أصبحت فيما بعد: الكليّة السوريّة الإنجيليّة ثمّ هي اليوم الجامعة الأميركيّة في بيروت.
ومِن رأي المبشّرين أنْ تؤسَّس الكليّات في المراكز الإسلاميّة، ولذلك لم يكتفوا ببيروت، بل أرادوا أنْ تكون ثمّة كليّة في القاهرة نفسها إلى جانب الأزهر.. ولم يكن رأي المبشّرين الفرنسيّين مخالفاً لذلك فأنشأوا كليّة لهم في مدينة لاهور، وهي مدينة من المدن الإسلاميّة الكبرى(٤) .
ي - انتهاج طريقة إحياء الفكر القومي والطائفي، والدعوة إلى تنظيم الحركات القوميّة العلمانيّة والطائفيّة على أساسه، لتكون الأساس في حركة المجتمع الإسلامي السياسيّة.
ولا تنفرد المدرسة الاستشراقيّة الفرنسيّة بهذه الميّزة نظريّاً، بل إنّها تمثّل رؤية عامّة لدى كافّة المدارس الاستشراقيّة. فهذا المبشر الشهير (صموئيل زويمر) أحد كبار المستشرقين يقول: (إنّ أوّل ما يجب عمله للقضاء
____________________
(١) Revue D Historie Des Missions p. ٣٣٤. ٣٣٥،
(٢) Milligan ١٢٤ – ٥.
(٣) Milligan ١٦٤.
(٤) الدكتور خالدي، مصطفى والدكتور فروخ، عمر - التبشير والاستعمار في البلاد العربيّة: ٧٩.
على الإسلام إيجاد القوميّات)(١) ، وعلى ضوء ذلك (ولِدت فكرة القوميّة اللبنانيّة المسيحيّة. هذه الفكرة التي شجعتها الأوساط السياسيّة الدينيّة الفرنسيّة، ميّزت تلك الفترة من تاريخ لبنان)(٢) ، ولابدّ لأجل تحقيق هذا الهدف الكبير من توفير المستلزمات الأساسيّة لذلك خصوصاً على أرض الشرق وفي وسط مجتمعاته، فعمدوا إلى إنشاء المدارس والجامعات التي تقوم أساساً على التنظير للفكر القومي والطائفي، وتتعهّد طلاّبها بالإعداد والتربية وفق منهج ذلك الفكر، وأساليب التعليم الغربيّة المتّبعة في أوربّا.
ومن أبرز أمثلة ذلك هو (قيامهم في عام ١٨٦٥م بإنشاء الكليّة السوريّة الإنجيليّة [ الجامعة الأميركيّة حالياً ] في بيروت والتي وصفت جريدة (الديار) - في عددها المرقم ١٩١١ الصادر في ١٠ تموز ١٩٤٩م - طلاّبها بأنّهم [ رسل القوميّة العربيّة إلى أنحاء الشرق العربي ](٣) .
وكان أوّل ثمرةٍ لهذا التخطيط المدروس (عصبة العمل القومي)، وهي أوّل منظمة قوميّة ولِدت في ظروف التصارع بين أطراف الاستكبار العالمي حينذاك، وخصوصاً بين الفرنسيّين والانجليز.. وكانت فرنسا قد ثبّتت نفوذها في لبنان وسوريا، وأوجدت لها قواعد فكريّة وسياسيّة، وامتلكت العديد من المؤسّسات الثقافيّة كالجامعات والمدارس ونحوها، التي أصبحت فيما بعد بمثابة مراكز لتخريج كوادر سياسيّة وفكريّة مدرّبة لصالح فرنسا(٤) .
ك - إنشاء الكليّات والمعاهد العلميّة والثقافيّة في البلاد الإسلاميّة، تحت إشراف وإدارة المستشرقين الفرنسيّين، واعتمادها وسيلةً لنشر الفكر العلماني
____________________
(١) مجلّة رسالة الجهاد - ليبيا: العدد ١٤.
(٢) الصليبي، كمال - تاريخ لبنان الحديث: ١٥٢.
(٣) مجلّة رسالة الجهاد - ليبيا: العدد ١٤.
(٤) للمؤلّف - السياسة الفرنسيّة في الشرق الأوسط: ١١٥.
المعادي للإسلام.
وباستقراءٍ لنماذجٍ مختارة من المشاريع التعليميّة لفرنسا في الشرق، يظهر بوضوح الهدف التخريبي المعادي للإسلام من إنشائها.
منها إنشاء أوّل بعثة يسوعيّة في سوريا عام ١٦٢٦م، وهي التي كانت تُدار من قِبل المشرف العام في (فرنسا ليون)، والتي نقلت إلى بيروت سنة ١٨٧٥م، فإنّها بعد ذلك تحولت إلى ما يسمّى بـ (جامعة القديس يوسف)، وفي عام ١٨٨١م، اعترف البابا (ليون الثالث عشر) بالصفة الجامعيّة لهذه المؤسّسة، الذي أنشأ بأمر كنسي (كليّة الفلسفة والعلوم الدينيّة للدراسات الشرقيّة) [أيّ الاستشراقيّة](١) .
وقد توسّعت هذه المؤسّسات التعليميّة بعد ذلك توسّعاً كبيراً في لبنان وسوريا وشمال إفريقيا، وشكّلت عنصراً أساسيّاً في الكيان الاستكباري الفرنسي لما تمثّلته من أهدافٍ كبرى له، فقد (كان لابدّ من إنشاء طبقة حاكمة لهذا الشعب المسيحي المستعبد والمنهك من قِبل المشركين، كان لابدّ من تشكيل طبقة وسطى.
يُضاف إلى ذلك: إنّ مجمل هذا الجزء من الشرق الأدنى كان بحكم الواقع، ومن خلال علاقاته الطبيعيّة قد أنجر وراء حضارة الغرب الماديّة، وبدل الوقوف ضدّ تيّار لا يقاوم فضّل السير معه.
والأكثر من ذلك هو أنّ اليسوعيّين في سوريا كانوا يسعون إلى تصدير هذا التيّار لكي يتسنّى لهم قيادته)(٢) ، وحينما فرض الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان عام ١٩١٩م فرض معه منهاج التعليم الرسمي الذي كان يُساعد المبشرين في أعمالهم(٣) ، (وكانت مدارس الإرساليّات الكاثوليكيّة تحبّب فرنسا إلى التلاميذ النصارى)(٤) .
____________________
(١) مجلّة المنتقى/ العدد الأوّل - ابريل ١٩٨٣م: ٦٩.
(٢) شارلس - تقرير عن البعثات اليسوعيّة - باريس ١٩٢٩م/ عن مجلّة المنتقى/ العدد الأوّل ٦٩.
(٣) Les Jesuites En Syrie ١٠ : ٦٥.
(٤) Ibid, ٢ : ٨.
يقول(ساطع الحصري) وزير التربية السوري في عهد فيصل: (إنّ النُظُم العديدة التي وضِعَت في سوريا، في عهد الانتداب الفرنسي، إنّما كانت تنفيذاً لسياسةٍ مرسومةٍ بوضوحٍ وإتقان، ونستطيع أنْ نقول: إنّ غاية هذه السياسة كانت تأمين سيطرة الثقافة الفرنسيّة والنظُم الفرنسيّة على معارف البلاد، سيطرةً مطلقةً من غير التفات إلى ما تتطلّبه أُصول التربية السليمة والعلم الصحيح.
إنّها كانت (تعطي للغة الفرنسيّة وللشهادات الفرنسيّة امتيازات مهمّة، وتتحيّز للمعاهد التعليميّة الفرنسيّة تحيّزاً مفرطاً، يجعلها أحياناً ليست صاحبة امتياز فحسب، بل صاحبة انحصار واحتكار أيضاً)(١) .
ومن تلك النماذج أيضاً إنشاء كليّة الطب في سوريا، والتي عبّر عنها السفير الفرنسي في القسطنطينيّة بالإشادة بـ(غامبيثا) والكاردينال(لافيجري) صاحبي فكرة الكليّة [كليّة الطبّ]، اللذين أرادا إيجاد مدرسة فرنسيّة في سوريا، يؤمّها شبّان البلد من أجل العلوم الطبيّة، والتعمّق في دراسة لغتنا، كي ينتشروا فيما بعد في أنحاء الشرق كافّة، كأصدقاء لنفوذنا وحضارتنا(٢) .
وفي عام ١٨٨٩م أُلحق بكليّة الطب كليّة الصيدلة، ومنذ ذلك الحين أُلغيَ التمييز بين الدبلوم الفرنسي وبين الدبلوم المُعطى في بيروت.
كما أُلحقت كليّة الطب في بيروت بكليّة الطب في ليون، وأُتْبِعت ماليّاً للمساعدات الحكوميّة، وهكذا غدت مع كليّة الصيدلة (أرضاً رائعةً للتوسّع الفرنسي، تخرّج منها حوالي ٥٣٥ طبيباً، يحملون الدبلوم الفرنسي، ويبشّرون بنفوذنا، وبفعاليّة طرائقنا العلميّة لا في
____________________
(١) تقارير عن أحوال المعارف في سوريا / عن الدكتور الخالدي مصطفى والدكتور فروخ، عمر - التبشير والاستعمار في البلاد العربيّة: ٨٦.
(٢) أرشيف وزارة الخارجيّة الفرنسيّة - رسالة من سفير فرنسا في القسطنطينيّة إلى وزير الشؤون الخارجيّة في أكتوبر (ت ١) ١٨٩٨م / عن الدكتور عتريسي، طلال - البعثات اليسوعيّة: ١٣٠.
سوريا فقط، بل في الإمبراطوريّة العثمانيّة بأسرها، وحتّى في فارس ومصر...)(١) .
ويؤكّد الهدف غير العلمي لمثل هذه المعاهد والكليّات تحديد أحد المسؤولين الفرنسيّين لأهداف كليّة الطب اليسوعيّة في بيروت قائلاً: (إنّ غاية المؤسِّسين [غامبيثا والكاردينال لافيجري] الأولى، أنْ يجعلا من هذه الكليّة فكرة سياسيّة ومؤسّسة دعائيّة..)(٢) .
والذي يؤكّد هذه السياسة الفرنسيّة الوثائق الدامغة المتمثّلة في مراسلات القناصل السياسيّة الفرنسيّة، نشير إلى نماذج منها:
١ - وثيقة رقم(١) :
تركيا - بيروت مجلّد رقم(٢) ١٨٤٠ - ١٨٤١م.
بيروت ١٨ كانون الثاني (يناير) ١٨٤١م.
من ج. بريتون إلى الوزير غيزو سكرتير الدولة في وزارة الشؤون الخارجيّة.
.. كنت قد قدّمت في شهر آيار عام ١٨٤٠م إلى حضرة وزير الشؤون الخارجيّة، بعض الملاحظات حول إنشاء كليّة في سوريا، وكانت الموافقة قد تمّت على تصميم المشروع في روما في بداية ١٨٣٩م... هذه المؤسّسة ستؤثّر بشكل إيجابي جدّاً على مصالح فرنسا راهناً ومستقبلاً؛ لأنّها ستلبّي حاجةً ملحّة لدى المسيحيّين، وستنشر بينهم، تحت الإشراف الفرنسي، المعارف الأخلاقيّة، والعلميّة، والصناعيّة...
إنّ مسيحيّي لبنان وسوريا بأكملها يتمنّون افتتاح كليّة آسيويّة؛ لأنّهم يشعرون بأنّها ستكون نواة انبعاثهم الاجتماعي... حين ننشر في هذا البلد بواسطة اللغة الفرنسية، التعليم، والأخلاق، والفنون المفيدة، والزراعة، فإنّنا
____________________
(١) R. Risteihueber Traditions Francaises Au Liban Paris ١٩١٨ p. ٢٧٩.
(٢) الدكتور عتريسي، طلال - البعثات اليسوعيّة: ١٢.
سنسيطر على الشعب، وسيكون لفرنسا هنا في كلّ وقتٍ جيشٌ متفان.
٢ - وثيقة رقم(١٤) : مراسلات القناصل السياسية تركيا - بيروت - مجلّد رقم(٢) .
إنّ الإمبراطوريّة العثمانيّة تتلاشى، لكن سورية بموقعها الجغرافي بين آسيا الصغرى ومصر، تعتبر مركز هذه الإمبراطوريّة، لا بل قلبها، كما تملك في الوقت نفسه إمكانيّة لإعادة الحياة التي انحسرت عن أطراف هذا الجسم الكبير.
أمّا أمر ذلك فمنوطٌ بفرنسا، بأنْ تؤسّس وسط الشعب السوري كلّية كبيرة دينيّة مدنيّة، وزراعيّة، يكون هدفها إدخال الحضارة الفرنسيّة إلى سورية، وتعميم اللغة الفرنسيّة فيها، وتأمين هيمنة بلدنا على منطقة خصبة ومنتجة وفي خلال علاقاتنا المزدوجة، السياسية والتجاريّة مع هذا البلد، يمكن أنْ نجني أكثر العلاقات نفعاً...
إنّ إنشاء مؤسّسة تكون في الوقت نفسه كليّة دينيّة، ومزرعة نموذجية، ومدرسة للفنون والمِهَن، ليس خرافة، فقد وافق الأب القديس (غريغور السادس عشر) على تصميم المشروع وأمر بتنفيذه، والأساتذة حاضرون. إنهم رجال كرام من جمعية يسوع تطوّعوا بملء إرادتهم لهذا العمل... هكذا نجعل من سورية حليفاً أكثر أهمية من مستعمرة، لانها ستكون منتجة لنا دون أيّ تضحية في المال والأنفس.
إذن يجب ألاّ نناقش مسألة إرسال اليسوعيين إلى سورية، بل علينا أنْ نعمل لجعل وجودهم في هذا البلد مفيداً لمصالح فرنسا. على أيّ حال، يجب الاعتراف بأن اليسوعيين هم خير العاملين.
(دون توقيع ودون تاريخ ومن المحتمل أنّها كُتبت بين عامي ١٨٤٠ - ١٨٤٤ نسبة
إلى وثائق أُخرى)(١) .
٣ - الوثيقة رقم(٩) : سفارة فرنسا لدى الباب العالي.
الإدارة السياسيّة رقم ٢١٧.
١٨ ت ١ (أكتوبر) ١٨٩٨م، سعادة الوزير Delcasse وزير الشؤون الخارجيّة في باريس.
حول كليّة الطب في بيروت:
تعود فكرة تأسيس هذه الكليّة إلى (غامبيثا) والكاردينال (لافيجري)، والهدف من الفكرة إيجاد كليّة فرنسيّة كبيرة في سورية يأتي إليها شبّان هذا البلد ليتعلّموا فيها العلوم الطبيّة، ويتمكّنوا من دراسة لغتنا، كي ينتشروا في المشرق، فيما بعد، على غرار الكثير من أصدقاء نفوذنا وحضارتنا.
إنّ الغاية الأُولى للمؤسّسين أنْ يجعلا من هذه الكليّة فكرة سياسيّة ومؤسّسة دعائيّة.
(التوقيع غير واضح)
ل - تبنّي العمل الاستشراقي وتزويده بكلّ عوامل القدرة والحركة بهدف أنْ تكون فرنسا كعبة للاستشراف ومدارسه، وجعل اللغة الفرنسيّة بديلاً أساسيّا عن اللغة العربيّة، ولهذا نجد أنّ العلاقة على مستوى التخطيط والتنظير بين الاستشراق والتبشير من جهة، والتوجّهات الاستعماريّة الفرنسيّة من جهة أُخرى، علاقة موضوعيّة مترابطة، كعلاقة أجزاء الشيء الواحد ببعضها، وتنعكس هذه العلاقة على الواقع العملي لتكشف بشكل أوضح، عند المتتبّع الهادف، الترابط الميداني بين هذا الثالوث المُبرمج، بشكلٍ لا يمكن فصل أحدها عن الآخر، وإلاّ
____________________
(١) جميع الوثائق المشار إليها أعلاه عن الدكتور عتريسي، طلال - البعثات اليسوعيّة: ٩١.
اختلّت المعادلة وتخلّفت النتائج الحقيقيّة المُستهدفة عن التحقّق في الواقع، وهذا يُفسّر لنا كيف أنّ فرنسا تريد أنْ تصبح قبلة الاستشراق والتبشير العالمي؛ لتضمن لنفسها حركة استعماريّة واسعة وفاعلة في عمق الشرق، وبأكبر مدى زماني مُمكن.
ويؤكّد ذلك( إنّ الدراسات الشرقيّة التي شاعت مجدّداً والتي بدت بالفعل وكأنّها عصر نهضة، زوّدت(الرومانتيكيين) بكنوزٍ من المعلومات، ومع ذلك فإنّ جذور الاستشراق العلمي ترجع إلى اهتمامات حركة التنوير، وكان كلّ شخص في أوربّا يرغب في التعرف بطريقة وافية على لغات الشرق الأدنى وحضاراته يتوجّه إلى مدرسة اللغات الشرقيّة الحيّة في باريس التي أسّستها حكومة المؤتمر الثوريّة(الكونتانسيون) في مارس ١٧٩٥م بإيعاز من(لانغليز).
وقد أصرّ هذا الأخير بصورة خاصّة على عنصر الفائدة العمليّة، ولكنه أكّد أيضاً ما يُمكن أنْ تسهم به اللغات الشرقية في تقدم الأدب والعلم) (١) .
ومن المفارقات أن يكون الرائد الكبير في هذا المجال هو(سلفستر دوساسي) ، الذي أصبح أُستاذ جميع المستشرقين الاوربيين، وأصبحت باريس الكعبة التي يؤمّها جميع الذين يرغبون في التخصص بدراسة الشرق الأدنى(٢) .. وبقي اسلوبه في العمل حتى يومنا هذا هو الأسلوب الذي يتبعه عدد كبير من المستشرقين(٣) .
وفي سعيهم الهادف الى جعل اللغة الفرنسيّة بديلاً أساسيّاً عن اللغة العربيّة كتب المستعمرون الفرنسيّون في أحد التقارير التي وضعت سنة ١٨٤٨م: (إنّ
____________________
(١) Fuck, op. Cit, p. ١٤١.
(٢) Fuck, op. Cit, pp. ١٤٠ ٥٨ ; H Deherain, Silver De Sacy, Ses Contemporains Et SES Sicciples (paris, ١٩٣٨).
(٣) شاخت وبوزورث - ترجمة الدكتور السمهوري، محمّد زهير - تراث الإسلام (القسم الأوّل) - عالم المعرفة: ٧٥.
الجزائر لنْ تصبح فرنسيّة إلاّ عندما تصبح لغتنا الفرنسيّة لغة قوميّة فيها، والعمل الجبّار الذي يتحتّم علينا إنجازه، هو السعي وراء جعل الفرنسيّة اللغة الدارجة بين الأهالي إلى أنْ تقوم مقام العربية، وهذا هو السبيل لاستمالتهم إلينا، وتمثّلهم بنا، واندماجهم، وجعلهم فرنسيّين)(١) .
م - الدعوة إلى بعث الحضارات القديمة وإحياء اللغة العاميّة مقابل اللغة العربيّة الفصحى.
ولا يخفى إنّ الهدف من وراء هذا الأسلوب هو إعادة الشرقيّين إلى أُصولهم الجاهليّة قبل الإسلام، وإبعادهم عن أُصول ومصادر دينهم الحنيف.
يقول المستشرق الشهير(جب) : (.. وقد كان مِن أهمّ مظاهر فرنجة العالم الإسلامي تنمية الاهتمام ببعث الحضارات القديمة، التي ازدهرت في البلاد المختلفة التي يشغلها المسلمون الآن، فمثل هذا الاهتمام موجود في تركيا وفي مصر وفي اندونيسيا وفي العراق وفي إيران، وقد تكون أهميّته محصورة الآن في تقوية شعور العداء لأوربّا، ولكن مِن الممكن أنْ يلعب في المستقبل دوراً مهمّاً في تقوية الوطنيّة الشعوبيّة وتدعيم مقوّماتها)(٢) .
وفي سبيل إحياء اللغة العاميّة مقابل اللغة العربية الفصحى. يقول المستشرقون وتلاميذهم بكلّ قوّة: (إنّ لغة القرآن الفصحى إنّما هي لا تساير حاجات العصر، فيجب أنْ تعمّ اللغة العاميّة حتّى تصبح لغة الجرائد والمؤلّفات)(٣) . وقد تكرّرت منهم هذه الدعوة بصورة شائقة جذّابة كسبت تأييد المثقّفين في مصر وأوقفتهم بجانبها، وقد عنيت حكومات الاحتلال وبعيدو النظر من الولاة والمستعمرين والمفكّرين الغربيّين بهذا الموضوع عناية فائقة، ونشطوا
____________________
(١) الدكتور عمارة، محمّد - الأُمّة العربيّة وقضيّة التوحيد: ٩٦ - ٩٧.
(٢) جب - وجهة الإسلام: ٣٤٢.
(٣) حسين، محمّد محمّد - الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر: الجزء الثاني.
في تحبيب هذه الفكرة وترويجها، وقد كان لهذه الدعوة دويٌّ في مصر في فجر هذا القرن، أفزع كثيراً من المحبّين للإسلام والغيارى على اللغة العربيّة(١) .
أثر المدرسة الاستشراقيّة الفرنسيّة على الفكر الاستشراقي العام
خلال السنوات الأُولى من القرن العشرين، كان بإمكان رجال مثل(بلفور وكرومر) أنْ يقولوا ما قالوه، وبالطريقة التي بها قالوه، لأنّ تراثا من الاستشراق أقدم من تراث القرن التاسع عشر، زوّدهم بمفردات وصور وبلاغة ومجازات ليقولوه بها، ومع ذلك فإنّ الاستشراق عَزّز وعُزّز بالمعرفة الأكيدة لكون أوربّا أو الغرب تسيطر، بمعنى الكلمة الحرفي، على الجزء الأعظم من سطح الأرض.
ذلك أنّ مرحلة التقدّم الضخم في مؤسّسات الاستشراق وفي مضمونه، تواكبت تماماً مع مرحلة التوسّع الأوربّي الفريد، فمن ١٨١٥م إلى ١٩١٤م اتّسع مجال السيطرة الأوربيّة الاستعماريّة المباشرة من حوالي ٣٥% من سطح الأرض إلى حوالي ٨٥% منه.
وقد تأثّرت بهذا التوسّع جميع القارّات، وبشكلٍ خاص إفريقيا وآسيا، وكانت الإمبراطوريّتان العُظميان: الإمبراطوريّة البريطانيّة، والإمبراطوريّة الفرنسيّة، اللتان كانتا حليفتَين وشريكَتين في بعض الأشياء، ومتنافستين ومتعاديتين في أشياء أُخرى؛ وكانت ممتلكاتهم المستعمرة ومجالات نفوذهما الإمبراطوريّة في الشرق، من شواطئ المتوسّط الشرقيّة إلى الهند الصينيّة، والملايو، متلاصقةً وأحياناً كثيرةً متداخلةً، وكثيراً ما دارت حولها الحروب،
____________________
(١) الندوي، السيّد أبو الحسن عليّ الحسيني - الصراع بين الفكرة الإسلاميّة والفكرة الغربيّة: ١٨٦.
غير أنّ الشرق الأدنى أو بلدان الشرق الأدنى والعربي - حيث كان الإسلام قد حدّد الخصائص الثقافيّة والعِرقيّة - كان المجال الذي واجه فيه البريطانيّون والفرنسيّون أحدهما الآخر، و(الشرق) بأكثر درجات الحِدّة والتوتّر، والأُلفة والتعقيد.
وطوال معظم القرن التاسع عشر، كما قال لورد - الزبري عام ١٨٨١م، كانت وجهة نظرهما المشتركة للشرق إشكاليّة بصورة معقّدة: (حين يكون لديك... حليفٌ وفيٌّ مصمّم على أنْ يتدخّل في بلدٍ أنت عميق الاهتمام به، فإنّ أمامك ثلاث سُبل للتصرّف، فقد تشجب، أو تحتكر، أو تشارك.
أمّا الشجب فإنّه كان سيؤدّي إلى وضع الفرنسيّين عبر طريقنا إلى الهند؛ والاحتكار كان سيعني الاقتراب جدّاً من المخاطرة بالحرب. وهكذا عقدنا العزم على المشاركة)(١) .
(وقد شاركوا فعلاً... إلاّ أنّ ما شاركوا به لم يكن أرضاً أو أرباحاً أو حكماً وحسب، بل كان القوّة الفكريّة التي ما فتئتُ اسمّيها الاستشراق، وبمعنىً ما، كان الاستشراق مكتبة أو سجل حفظ (أرشيفاً) من المعلومات المشتركة، وفي بعض جوانبها، الممتلكة بصورة جماعيّة، وكان ما يضمّ هذا الملف إلى بعضه بعضاً أسرة من الأفكار، وطقماً من القِيم الموحّدة، برهن بطرقٍ مختلفة أنّها فعّالة)(٢) .
إنّ المبادرة والسبْق الذي تميّزت به المدرسة الاستشراقيّة الفرنسيّة وتبنّيها لمنهج يتناول أساسيّات العمل الاستشراقي، جعل من باريس كعبةً لجمعَيّ المستشرقين الأوربيّين، الأمر الذي أثّر على مجمل المدارس الاستشراقيّة الأوربيّة في الطريقة والأُسلوب، وفي المنهج والأهداف.. ويثبت هذه ما قاله كل من(شاخت وبوزورث) وهما يسردان أُصول وآثار الاستشراق الفرنسي، على عموم الاستشراق الأوربّي: قائلين: (وكان كلُّ شخص في أوربّا يرغب في
____________________
(١) سعيد، إدوارد - الاستشراق: ٧٢.
(٢) المصدر السابق.
التعريف بطريقة وافية على لغات الشرق الأدنى وحضاراته، يتوجّه إلى مدرسة اللغات الشرقيّة الحيّة في باريس، التي أسّستها حكومة المؤتمر الثوريّة(الكونفانسيون) في مارس ١٧٩٥م بإيعاز من(لانغليز) ... ومن المفارقات أنْ يكون الرائد الكبير في هذا المجال هو(سلفستر دوساسي) ، الذي أصبح أُستاذ جميع المستشرقين الأوربيّين، وأصبحت باريس الكعبة التي يؤمّها جميع الذين يرغبون في التخصّص بدراسة الشرق الأدنى... وبقي أُسلوبه في العمل حتّى يومنا هذا هو الأُسلوب نفسه الذي يتّبعه عددٌ كبير من المستشرقين)(١) .
____________________
(١) شاخت وبوزورث - ترجمة الدكتور السمهوري، محمّد زهير، تراث الإسلام (القسم الأوّل) - عالم المعرفة.
الفصل الرابع
نماذج من أبرز الموضوعات التي ركّز عليها المستشرقون دسّهم وتشويههم
* القرآن الكريم
* إعجاز القرآن الكريم
* الوحي القرآني
* ترجمة القرآن للّغات الأخرى
* سيرةُ الرّسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأهل بيته (عليهم السلام)
لمّا كانت أغلب دوافع الاستشراق - كما ذكرنا سابقاً - إمّا تبشيريّة أو استعماريّة، أو إنّها مستوحاة منهما وتصبّ في غاياتهما، فإنّ أبرز الموضوعات التي سيتناولها المستشرقون ستكون موضوعات الدين الإسلامي الذي حل محل النصرانية في اغلب بلدان الشرق، ووقف في طريق امتدادها وامتداد دولها في تلك البلدان، بل إنّه ظلّ على مدى التاريخ المقارع والمنافس الرئيسي لها بين الشعوب، واستطاع أنْ يغزوها في عقر دارها، كما حصل في غرب أوربّا مستولياً على إسبانيا إلى حدود فرنسا، وما حصل في شرق أوربّا إلى حدود الصين، وكذلك في وسطها إلى حدود النمسا.
وبهذا الصدد قال أحدهم وهو المستشرق الألماني(بيكر) : (... إنّ هناك عِداءً في النصرانيّة للإسلام بسبب أنّ الإسلام عندما انتشر في العصور الوسطى أقام سدّاً منيعاً في وجه انتشار النصرانيّة، ثمّ امتدّ إلى البلاد التي كانت خاضعة لصولجانها.
ويقول آخر وهو(لورانس براون) :( إنّ الخطر الحقيقي كامن في نظامه [الإسلام] وفي قدرته على التوسّع والإخضاع وفي حيويّتهِ، إنّه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوربّي)(١) ، ولا شكّ في أنّ أوّل أساس يقوم عليه الإسلام والثقل الأكبر فيه وفي ارتباط المسلمين به، عقيدةً وديناً، هو القرآن الكريم باعتباره كلام الله ووحيه لرسوله محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وثاني هذه الأُسُس
____________________
(١) راجع: د. خالدي، مصطفى. ود. فروخ، عمر (التبشير والاستعمار في البلاد العربيّة). وراجع أيضاً: جريدة البلاغ الكويتيّة. العدد ٥٨ ص١٢.
وراجع أيضاً: مجلّة البعث الإسلامي الهنديّة العدد ٩ السنة ٨.
والمقوّمات هي سيرة رسول الإسلام (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأهل بيته الطاهرين (عليهم السلام).
وبمرور سريع على كتابات المستشرقين تتأكّد دعوانا هذه، فنجد أنّ أكثر ما تناولوه بالدسّ والتشويه وركّزوا شبهاتهم عليه في كتاباتهم هما هذان الأساسان، فلنرَ ماذا كتبوا عنهما! على إنّنا سنتناول أهمّ تفاصيل الدسّ والتشويه وبيان مغالطاتهم فيها، وكذلك الردّ على أهمّ شبهاتهم المُثارة حول هذين الأساسَين في الفصل القادم.
القرآن الكريم
من خلال استعراض كتابات جميع المستشرقين وأعمالهم التي تناولوا فيها القرآن، نجدها مليئةً بالشبهات وإثارات التشكيك والتشويه حول جوانب أساسيّة، هي المقوّم الرئيسي له بصفته كتاباً سماويّاً كريماً - على اختلاف في درجات ومستويات التشكيك والشبهة والتشويه - ومن أبرزها هي:
إعجاز القرآن الكريم
الهدف الأساسي من وراء التشكيك ونفي إعجاز القرآن الكريم، في أسلوبه البلاغي وإخباراته الغيبيّة وحقائقه العلميّة واضح، وهو إسقاط الدليل الذي يثبت سماويّته وخلوده بخلود جوانب إعجازه من جهة، وإسقاط دعوى نبوّة محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وإرساله من قِبل الله تعالى للعالمين من جهة أُخرى.
وبذلك يفقد القرآن الكريم والنبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قدسيّتهما لدى المسلمين، تلك القدسيّة القائمة على أساس أنّ القرآن الكريم كلام الله، أوحاه لنبيّه محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وعندها يصبح شأن القرآن لديهم شأن أيّ كتاب بشري يطاله التغيير والتعديل أو الإهمال، وما (محمّد) إلاّ رجلٌ متميّز بذكاءٍ وقدرةٍ اجتماعيّة استطاع من خلالها أنْ يُهيمن على قومه ويقنعهم بأساليبه النفسيّة، أنّه نبيٌ ورسولٌ لهم من الله بهذا القرآن.
وفي مقدّمة من أورد
الشبهات وأثار التشكيكات في هذا الجانب من المستشرقين هو المستشرق الانجليزي(دافيد صموئيل مرجليوث) الذي سبقت منّا ترجمة مختصرة له، والذي ركّز شبهاته على إثارة الشكّ برواية الشعر العربي الجاهلي، فلعلّ في الشعر الجاهلي الذي لم يُروَ ما هو أبلغ من القرآن.
وذلك لمنزلة الشعر الجاهلي باعتباره أمارة وعلامة على بلاغة القرآن وفصاحته، وهذا القول يطوي تحته تشكيكا في الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم.
وممّن في المقدّمة أيضاً المستشرقان(كارل فلرِّس) (١) ، و(پاول كراوس) (٢) اللذان يدّعيان أنّ القرآن لم يكن معرباً، وان اللغويّين هُم الذين حذوه على مثال لغة الشعر العربي، الذي يتميّز بوجود الإعراب في مقابل اللهجة الملكيّة، التي كانت على زعمهما غير معربة(٣) .
ويُمكن تلخيص محاولتهم هنا بلحاظ وجهين رئيسيّين(٤) :
الوجه الأوّل :
محاولة إبراز النقص والخطأ في الأسلوب والمحتوى القرآني، من خلال ثلاث شبهات:
الشبهة الأولى: بما إنّ المرتكز الرئيسي للإعجاز القرآني هو الفصاحة والبلاغة القرآنيّة، ولما كنا نجد في القرآن الكريم بعض الآيات التي لا تنسجم مع
____________________
(١) مستشرق ألماني (١٨٥٧ - ١٩٠٩م).
(٢) مستشرق ألماني من أصل تشيكوسلوفاكي (١٩٠٤ - ١٩٤٤م).
(٣) الجندي، أنور - مخطّطات الاستشراق - مجلّة منار الإسلام - العدد ٧ - السنة ١٤.
(٤) في عرض الشبهات حول الإعجاز القرآني، تراجع المصادر التالية:
أ - الخوئي، أبو القاسم - البيان.
ب - البلاغي، محمّد جواد - الهدى إلى دين المصطفى.
ح - الحكيم، محمّد باقر - علوم القرآن.
د - ابن نبيّ، مالك - الظاهرة القرآنيّة.
قواعد وأُسُس الفصاحة والبلاغة والنطق التي وضعها العرب، بل إنّها تخالفها، إذن يمكننا [والقول للمستشرقين] الادعاء بأن القرآن الكريم ليس معجزاً؛ لأنّه لم يسر على نهج القواعد العربيّة وأُصولها.
الشبهة الثانية: بالمقارنة بين القرآن والكتب الدينيّة الأُخرى كالتوراة والإنجيل، نجده عنها عندما يتحدّث عن قصص الأنبياء، في حوادث كثيرة ينسبها إلى الأنبياء وأُممهم، وهذا يدعونا للشكّ في أنْ يكون مصدر القرآن هو الوحي الإلهي؛ وذلك لانّ الكتب الدينيّة الأُخرى هي من الوحي الإلهي باعتراف القرآن، فكيف يُناقض الوحي نفسه في الإخبار عن حوادث تاريخيّة واقعيّة؟
ثمّ إنّ هذهِ الكتب الدينيّة لا زالت تتداولها أُمم هؤلاء الأنبياء، وهُم بطبيعة ارتباطهم الديني والاجتماعي بأنبيائهم أدقّ اطّلاعاً على أحوالهم من القرآن، الذي جاء في أُمّةٍ ومجتمعٍ منفصلَين عن تاريخ هؤلاء الأنبياء.
الشبهة الثالثة: إنّ أُسلوب القرآن في تناول الأفكار والمفاهيم وعرضها لا ينسجم مع أساليب البلاغة العربيّة، ولا يسير على الطريقة العلميّة في المنهج والعرض؛ وذلك لأنّه يجعل المواضيع المتعدّدة متشابكة بعضها مع بعض، فهو حين يتحدّث في التاريخ، ينتقل إلى موضوع آخر من الوعد والوعيد والحكم والأمثال والأحكام وغير ذلك من الجهات، فلا يجعل القارئ قادراً على الإلمام بالأفكار القرآنيّة.
الوجه الثاني:
محاولة إثبات أنّ القرآن الكريم ليس معجزة، لقدرة البشر على الإتيان بمثله، وتمثّلت محاولاتهم بالشبهات التالية:
الشبهة الأولى: إنّنا لا نشكّ في أنْ يتمكّن ذوو القدرة والمعرفة باللغة العربيّة، من الإتيان بمثل بعض الكلمات القرآنيّة، فحين تتوفّر هذه القدرة في بعض
الكلمات فمن المعقول أنْ تتوفّر أيضاً في كلمات أُخرى، وهذا ينتهي بنا إلى أنْ نجزم بوجود القدرة على الإتيان بسورة أو أكثر من القرآن الكريم لدى أمثال هؤلاء؛ لأنّ من يقدر على بعض القرآن يُمكن أنْ نتصوّر فيه القدرة على الباقي بشكلٍ معقول.
الشبهة الثانية: إنّ العرب الذين عاصروا الدعوة أو تأخّروا عنها بزمنٍ قليل لم يُعارضوا القرآن الكريم، لا لعدم قدرتهم على ذلك، بل خوفاً على أنفسهم وأموالهم من المعارضة بسبب سيطرة المسلمين الدينيّة على الحكم، ومحاربتهم كل من يُعادي الإسلام أو يظهر الخلاف معهُ.
وحين انتهت السلطة إلى الأمويّين - الذين لم يكونوا مهتمّين بالحفاظ على الإسلام والالتزام به، الأمر الذي كان يفسح المجال لمن يُريد أنْ يعارض القرآن الكريم أنْ يُظهر معارضته - انصرف الناس عن التفكير بمعارضته؛ لأنّه أصبح من المرتكزات الموروثة لديهم، ولأنّ القرآن كان في ذلك الحين قد أصبح أمراً معروفاً ومألوفاً في حياة الأُمّة، بأُسلوبه وطريقة عرضه، بسبب رشاقة ألفاظه ومتانة معانيه.
الشبهة الثالثة: إنّ المعجزة لا يكفي فيها أنْ تكون مُعجزة لجميع البشر عن الإتيان بمثلها، بل لابدّ أنْ تكون صالحة لأْن يتعرّف جميع الناس على جوانب التحدّي فيها؛ لأنّها الدليل الذي بواسطته تثبت النبوّة، والقرآن ليس كذلك؛ لأنّ إعجازه في الأُسلوب البلاغي لا يكفي فيه عجز الناس عن الإتيان بمثله، بل لابدّ من معرفة جوانب التحدّي والإعجاز فيه من بلاغته وسموّ التعبير فيه، وهذه المعرفة لا تتوفّر إلاّ للخاصّة من الناس، الذين يُمارسون الكلام العربي البليغ، ويعرفون دقائق تركيبه وميزاته.
الوحي القرآني
إنّ موضوع الوحي مرتبطٌ بشكلٍ وثيق ببحث إعجاز القرآن؛ لأنّنا بإثباته نثبت أنّ القرآن ليس ظاهرة بشريّة، فهو إذن ليس من صنع محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وإنّ السرّ في كلّ ما فيه من جوانب تحدٍّ ناشئ من ارتباطه بعالم الغيب، وأيّة محاولة لنفي الوحي تعني فصل الرسول محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) والقرآن الكريم عن عالم الغيب، فلو أثبتنا إعجاز القرآن لكان دليلاً حاسماً على ارتباطهما بالغيب.
وقد انقسمت محاولات المستشرقين إلى قسمين: قسمٌ منهما حاول نفي الإعجاز لينفي بذلك دليل الوحي الكاشف عن الارتباط بالغيب، والقسم الثاني حاول إبراز شخصيّة الرسول محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) على أنّها شخصيّة ذات مَلَكات وقابليّات نادرة، كان ما أبدعه من قرآنٍ وحديثٍ وسيرة علامةً بارزةً على عبقريّته الفريدة، وبذلك طَوَوا مسألة الإعجاز ليُؤكّدوا على أنّ القرآن ظاهرة بشريّة من صنع محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وما يتراءى من أنّهُ إعجاز، ليس إلاّ نتاجُ عبقريّ بُهِرَ الناس به.
وبذلك تتكامل المحاولتان لضرب أساس الدين الإسلامي، وبالتالي انهيار عقيدة المسلمين، فينفتح الطريق أمام أُوربّا النصرانيّة لتغزو الشرق الإسلامي فكريّاً وحضارياً.
وتدرّجت محاولات المستشرقين في مسألة نفي الوحي القرآني فمنها ما كان بصيغة النفي المتعصّب الذي لا يلبث أنْ يكشف عن خلطه العلمي، ومنها ما ارتقى إلى المحاولات المُتقنة بأساليب التنظير العلمي والاستدلال البرهاني. ولنأخذ نماذج من ذلك ثمّ نختم الموضوع بخلاصّة جامعة لمقولاتهم.
فمثلاً يقول المستشرق البريطاني(مونتغمري وات) : (إنّ زيارة محمّد
لحراء، وهو جبل قريب من مكّة، بصحبة عائلته أو بدونها ليست مستحيلة، ويُمكن أنْ يكون ذلك للفرار من أُتون المدينة خلال فصل الصيف للذين لا يستطيعون التوجه الى الطائف)(١) .
ويحاول المستشرق(كازانوفا) (٢) في كتابه (محمّد ونهاية العالم) أنْ يثبت أنّ القرآن قد أضيف إلى الرسول محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بعد وفاته، وأنّه لم يكن وحياً من الله، وإنّما دعت الحاجة في نظر أبي بكر وعمر إلى نسبته إلى الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم).
أمّا المستشرقون (بول ديك) و(نولدكه)(٣) و(بور)(٤) و(جونت)، فقد ادّعوا أنّ فواتح السِّور ليست من القرآن في شيء، واختلفوا في نسبتها، فالأوّل قال: إنّها رموز لمجموعات الصحُف، التي كانت عند المسلمين قبل أنْ يوجد المصحف العثماني، والثاني ادّعى أنّ الحروف المقطّعة في أوائل بعض السِّور ما هي إلاّ اختصارات للأسماء القديمة لسور القرآن، وحاولا ترقيع هذهِ الاختصارات في أكثر من سورة واحدة.
أمّا المستشرقان (أبراهام جيجر) و(رودي باريت) فقد ادّعيا أنّ النبيّ محمّداً (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، قد استقى الكثير من تعاليم القرآن الكريم من كتب الأديان السابقة، فقال الأوّل منهما: (إنّ النبيّ قرأ كتب اليهود المختلفة، من التوراة والمكتوبات والأنبياء، و(المشناو)
____________________
(١) وات، مونتغمري - (محمّد في مكّة) - ص١٨.
(٢) كازانوفا (١٨٦١ - ١٩٢٦م): مستشرق فرنسي، أُستاذ أُصول العربيّة في الجامعة المصريّة، ترجم (الخطط) للمقريزي. عن المنجد (الأعلام)، ص٥٨٠.
(٣) نولدكه، ثيودور (١٨٣٦ - ١٩٣٠م) من مشاهير المستشرقين الألمان. ولد في همبورغ، اشتغل خصوصاً في اللغات السريانيّة والعربيّة والفارسيّة. له (تاريخ القرآن). عن المنجد (الأعلام) ص ٧١٩.
(٤) بور، دي (١٨٦٦ - ١٩٤٢) مستشرق هولندي - أُستاذ الفلسفة في أمستردام له، (الفلسفة في الإسلام) و(الغزالي وابن رشد). عن المنجد (الأعلام) ص١٤٨.
و(الجمارا)(١) ، وهي من كتب التلمود و(المدراش)(٢) و(الترجوم) وضمّن تعاليمها في القرآن الكريم). أمّا الثاني فقال: (إنّ النبيّ قد تأثّر في قرآنه بتعاليم النصرانيّة والبوذيّة، وعلى الأخص دعوة التوحيد والإيمان بالبعث والنشور، فالأولى في نظره من خصائص اليهوديّة، والثانية من تعاليم النصرانيّة).
ولعلّ من أخبث أساليب إثارة الشبهة حول الوحي، هو الأُسلوب القائل بما سُمّي بالوحي النفسي، الذي حاول أو يضفي على النبيّ محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، صفات الصدق والأمانة والإخلاص والذكاء، الأمر الذي أدّى به أنْ يتخيّل نفسه أنّه ممّن يُوحى إليهم.
فإنّ هذا الأُسلوب يُحاول أنْ يُستّر دوافعه المُغرِضة بمظاهر الإنصاف والمحبّة والإعجاب، وأبرز مَن فصّل في هذه الشبهة هو المستشرق الانجليزي (جب)(٣) ، وكذلك المستشرق (أميل درمنغام)(٤) على ضوء ما أجمله سابقهُ (مونتيه)(٥) .
ومن خلال ما أثاره المستشرق (جب) والمقدّمات العشر التي ساقها (درمنغام)،
____________________
(١) (لمشناو) هو الجزء الأوّل من التلمود، (الجمارا) الجزء الثاني من التلمود، وهي لفظةٌ أراميّة الأصل تعني (التكملة) أو (التتمّة)، ويعتبر شرحاً وملحقاً للجزء الأوّل من التلمود، وقد جُمع خلال فترة طويلة امتدّت من القرن الثالث إلى القرن الخامس للميلاد. عن البعلبكي، منير، موسوعة المورد المجلّد الرابع ص١٩٩.
(٢) (المدراش): مجموعة التفاسير التقليديّة للتوراة عند اليهود ويُرجّح الباحثون أنّها وُضِعت ما بين عام ١٠٠ ق، م وعام ٢٠٠م. واللفظة عبريّة الأصل، ومعناها (الشرح) أو (التفسير). عن البعلبكي، منير (موسوعة المورد) المجلّد السابع ص٢٧.
(٣) جبّ (غب)، هاملتون الكسندر Gibb Hamiton Alexandet Rosskeen ( ١٨٩٥ -...): مستشرق انجليزي. أُستاذ الدراسات العربيّة بجامعة هارفارد بالولايات المتحدّة الأميركيّة، طرح أفكاره في كتابه (المذهب المحمّدي) عني بدراسة التراث الإسلامي وتعريف الغربيين به. من أشهر آثاره: (دراسات في حضارة الإسلام) عام (١٩٦٢م) وقد نقله إلى العربيّة الدكاترة إحسان عباس ومحمّد يوسف نجم ومحمود زايد. راجع: البعلبكي، منير، موسوعة المورد - المجلّد ٤ ص٢١٥.
(٤) راجع كتاب (حياة محمّد).
(٥) مونتيه، ادوار (١٨٥٦ - ١٩٢٧م) مستشرق فرنسي ولد في ليون. له (حاضر الإسلام ومستقبله). عن المنجد (الإعلام) ص٦٩٦.
ورتّب عليها مقولة الوحي النفسي(١) ، نستطيع أنّ نصوغ الشبهة بالخلاصة التالية:
( إنّ محمّداً (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قد أدرك بقوّة عقلهِ الذاتيّة، وبما تمتّع به من نقاءٍ وصفاء روحي ونفسي، بطلان ما كان عليه قومه من عبادة الأصنام، كما أدرك ذلك أيضاً أفرادٌ آخرون من قومه، وإنّ فطرته الزكيّة - بالإضافة إلى بعض الظروف الموضوعيّة كالفقر - حالت دون أنْ يُمارس أساليب الظلم الاجتماعي من الاضطهاد، واكل المال بالباطل، أو الانغماس بالشهوات وارتكاب الفواحش، كالاستمتاع بالسكر والتسرّي، وعزف القيان وغير ذلك من القبائح، وإنّه طال تفكيره من أجل إنقاذهم من ذلك الشرك القبيح، وتطهيرهم من تلك الفواحش والمنكرات.
وقد استفاد من النصارى، الذين لقيهم في أسفاره أو في مكّة نفسها، كثيراً من المعلومات عن الأنبياء والمرسلين، ممّن بعثهم الله في بني إسرائيل وغيرهم، فأخرجوهم من الظلمات إلى النور، كما أنّه لم يقبل جميع المعلومات التي وصلت إليه من هؤلاء النصارى، كإلوهيّة المسيح وأمّه، وغير ذلك، وأنّه كان قد سمع أنّ الله سيبعث نبيّاً، مثل أولئك الأنبياء، من عرب الحجاز بشّر بهِ عيسى المسيح وغيرهُ من الأنبياء، وتولّد في نفسه أمل ورجاء في أنْ يكون هو ذلك النبيّ الذي آن أوانه.
وأخذ يتوسّل إلى تحقيق هذا الأمل بالانقطاع إلى عبادة الله تعالى في خلوته بغار حِراء،. وهنالك قوِيَ إيمانه وسما وجدانه، فاتّسع محيط تفكيره، وتضاعف نور بصيرته، فاهتدى عقله الكبير إلى الآيات والدلائل البيّنة في السماء والأرض، على وحدانيّة الله سبحانهُ وتعالى خالق الكون ومدبّر أموره، وبذلك أصبح أهلاً لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ثمّ ما زال يفكّر ويتأمّل ويتقلّب بين الآلام والآمال، حتّى تكوّن في نفسه يقين أنّه هو النبيّ المنتظر الذي يبعثه الله لهداية
____________________
(١) راجع رضا، محمّد رشيد، الوحي المحمّدي - الفصل الثالث ص٨٧ - ١١٠.
البشريّة، وتجلّى له هذا الاعتقاد في الرؤى المناميّة، ثمّ قوِيَ حتّى صار يتصوّر أنّ الملَك يتمثّل له ليلقّنه الوحي في اليقظة، وأمّا المعلومات التي جاءته من هذا الوحي، فهي مستمدّة في الأصل من تلك المعلومات التي حصل عليها من اليهود والنصارى، وممّا هداه إليه عقله وتفكيره في التمييز بين ما يصحّ منها وما لا يصح، ولكنّها كانت تتجلّى وكأنّها وحي السماء، وخطاب الخالق عزّ وجل، يأتيه بها الناموس الأكبر، الذي كان ينزل على موسى بن عمران وعيسى بن مريم، وغيرهما من النبيّين (عليهم السلام)) .
ولم يكتفِ هؤلاء المستشرقون بطرح شُبهاتهم هذهِ عن القرآن الكريم سَواء في مسألة الإعجاز أم مسألة الوحي، بل راحوا يدخلونها فقرات في المناهج والبرامج الدراسيّة لبعض الجامعات، وتبنّوا مجموعة من الطلبة المسلمين لاستئناف دراسات وأبحاث في هذين الموضوعين، إدراكاً منهم أنّ حساسيّة المسلمين تجاه ما يصدر عن غير المسلمين، خصوصاً ما يتعلّق بمعتقداتهم ومقدّساتهم، سيشكّل عَقَبة رئيسيّة في التأثير والتسليم بما يدّعيه هؤلاء المستشرقون.
إضافة إلى أنّ استئناف دراسة وبحث مثل هذهِ المسائل ذات العلاقة الموضوعيّة الوثيقة بتراث الإسلام والمسلمين، وخصوصاً العرب ولغتهم العربيّة، سيثري الشبهات المطروحة من قِبلهم، ويعمّق مطالبها من الناحية العلميّة، باعتبار إنّ هؤلاء المسلمين العرب هُم أعرف بدقائق لغتهم ومعتقداتهم. وفعلاً نجحوا في ذلك واستطاعوا من خلال أمثال الدكتور طه حسين(١) الذي فصّلَ كثيراً فيما ادّعوه
____________________
(١) طه حسين (١٨٨٩ - ١٩٧٣م) أديب وناقد مصري. درس في الأزهر والجامعة الأهليّة (المصريّة القديمة)، نال الدكتوراه فيها، ثمّ درس في جامعة السوربون، وتسنّم مناصب عديدة، منها عميد كليّة الآداب بجامعة القاهرة، ثمّ وزيراً للمعارف أيّام الحكم الملََكَي في مصر عام ١٩٥٠م، وعضواً بالمجمع العلمي العربي بدمشق، ورئيساً لمجمع اللغة بمصر. أسّس جامعتي: الإسكندريّة التي تولّى إدارتها عام ١٩٤٢م وجامعة عين شمس. لهُ عشرات الكتب الأدبيّة والنقديّة من أبرزها (في الأدب الجاهلي). = عن الزركلي، خير الدين الأعلام (قاموس تراجم) م٣ ص٢٣١، والمنجد - (الأعلام) - ص٤٣٧.
بشأن الشعر العربي الجاهلي، وكذلك أمين الخولي(١) وتلميذه الدكتور (خلف الله)، أنْ يصِلوا إلى مآربهم، خصوصاً فيما تناولوه بشأن الأُسلوب الفنّي للقصص والأخبار القرآنيّة، بدعوى أنّها لا يُلتزم فيها الصدق وتحرّي الواقع، وإنّما يعطي فيها القاص لنفسهِ الحريّة فيغيّر ويُبدّل ويزيد ويُنقص، وبهذا يحاولون أنْ يشكّكوا فيما جاء في القرآن من قصص الأنبياء والرسل والأمم، ويُحاولون الادّعاء بأنّ القرآن المعتمد على التمثيل والتشبيه لا يَنظر إلى الواقع، وبذلك يفقد المسلمون ثقتهم بجانب إخباراته الغيبيّ كأحد أدلّة إعجازه، وكونه وحياً من الله لا يأتيه الباطل ولا يطرأ عليه التبديل.
ترجمة القرآن للغات الأُخرى
في هذا الجانب تبرز بشكلٍ واضح النزعات العدائيّة للمستشرقين، ويتفاقم خطر الشذوذ الاستشراقي لديهم، إضافةً إلى السبب الذي يعود إلى عدم إيمانهم بالنص القرآني، وعدم تقديسهم للأمانة العلميّة في الترجمة، فتكون النتيجة مليئةً بالمغالطات الكبيرة، وقد كانت أغلب ترجمات القرآن إلى اللغات الشرقيّة والغربيّة هي ما تمّ على يد المستشرقين، حيث تُرجم ترجمةً كاملة إلى ٧٩ لغة، وترجمة ناقصة إلى ٤٩ لغة وأبرز ما يُؤخذ على هذهِ الترجمات هي:
____________________
(١) أمين الخولي (١٨٩٥ - ١٩٦٦م) مصري، تعلمّ بالأزهر وتخرّج من مدرسة القضاء الشرعي وعُيّن في الشؤون الدينيّة في السفارة المصريّة بروما، ثمّ انتقل إلى برلين، ثمّ أستاذاً في الجامعة المصريّة، القديمة، ثمّ وكيلاً لكليّة الآداب إلى سنة ١٩٥٣م. من أعضاء المَجمع اللغوي بمصر. مثّل مصر في عدّة مؤتمرات، له كتب لغويّة وأدبية متعدّدة.
عن الزركلي، خير الدين، الإعلام (قاموس تراجم)، ص١٦.
١ - أنّها ترجماتٌ مصوغةٌ صياغةً تُساعد على استنباط مبادئ مغايرة للنظريّات الإسلاميّة الصحيحة، كالذي قام به المستشرقان (جولد صيهر) و(الفريد غيوم).
٢ - أنّها ترجماتٌ حرّة غير ملتزمة، وموافقة لأهوائهم من حيث التصرّف بالنصوص عن طريق التقديم والتأخير والإهمال والتحوير، من قبيل ترجمتهم لقوله تعالى من سورة النساء: ( وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ... ) ، فقد ترجمها(سافاري آب) كالآتي: (لا تتزوّجوا النساء اللاتي كنَّ زوجات لآبائكم، تلك جريمة، إنّه طريق الضياع، ولكنْ إذا كان الشرّ قد حدث فاحتفظوا بهن)، وترجم(ماكس هانتج) لفظة (الإبل) إلى الألمانيّة في قوله تعالى من سورة الغاشية: ( أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ) ، بكلمة (فولكن Wolken ) أيّ سحاب.
أمّا(جورج سيل) (١) فقد ترجم خطاب ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ.... ) إلى (يا أهل مكّة)، وذلك بناءً على ادّعائه أنّ محمّداً (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كان يُريد إصلاح بني جِلدته وتقدّمهم اقتصاديّاً وسياسيّاً، ولم يقصِد إلى مخاطبة البشر كلّهم(٢) .
٣ - محاولة البحث عن القراءات الشاذّة، واتّخاذها ذريعةً لإيجاد الشكّ في وثاقة ومصدريّة القرآن.
٤ - كانت بعض عمليّات الترجمة لدحض المبادئ الإسلاميّة وتغييرها.
٥ - نشر الترجمات المضلّلة التي تنطوي على الحقد والتعصّب الأعمى.
____________________
(١) جورج سيل (١٦٩٧ - ١٧٣٦م) مستشرق بريطاني. درس العربيّة واهتم بالإسلاميّات. نشر مؤلّفات كثيرة، له ترجمة انجليزيّة شهيرة للقرآن. عن المنجد (الإعلام). ص٣٧٧.
(٢) الجندي، أنور، مخطّطات الاستشراق في ضرب العقيدة والقرآن والسنّة - مجلّة منار الإسلام العدد ٧ - السنة ١٤.
٦ - استخدام كلمات قديمة بائدة بحيث لا يفهمها المثقّفون الجُدد.
٧ - الترجمة قامت في كثير من الأحيان بأسماءٍ مُستعارة وفيها التضليل الكثير.
٨ - حاولوا من خلال ترجماتهم - خصوصاً الفرنسيّة منها - أنْ يبثّوا في الروع أنّ القرآن من وضع محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وأنّه كتابٌ متناقض وليس بكتابٍ يُوحى به من الله تعالى.
٩ - حاول بعض اليهود، ومنهم المستشرق(أبراهام جيجر) إثبات نظريّته الشرّيرة القائلة بأنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) اطلع على كتب اليهود بلغاتها المختلفة، وأخذَ منهم كلَّ ما يهمّه.
١٠ - عند متابعة المقدّمات التي وضعت قبل الترجمات، نجد التشهير بالإسلام وبالمسلمين وبالنبيّ بشكلٍ يأباه العلم والباحثون المنصفون.
١١ - حاولوا إثارة ترجمة القرآن حسب النزول لإيجاد حالة التشكيك والتردّد لدى المسلمين العاديّين والمثقّفين المتأثّرين بالثقافة الغربيّة.
هذهِ خلاصة لنماذج هي أبرز ما طالته يد المستشرقين للنيل من قدسيّة القرآن الكريم ومقامه باعتباره كتاباً إلهياً، وقد جاءت معبرة عن غاية خبثهم وعمق دوافعهم المعاديّة للإسلام وللأُمّة الإسلاميّة لتمهيد الطريق أمام حضارة أوربّا الاستعماريّة.
سيرة الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم)وأهل بيته (عليهم السلام)
لمّا كان الثقل الثاني من الدين الإسلامي بعد القرآن الكريم هُم أهل البيت (عليهم السلام)، وأصلُهم البارز ومبدأهم الأوّل وعمود نورهم المقوّم، هو الرسول محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، كان ثاني ما اهتمّ به المُستشرقون من موضوعات هذا الدين.
فتناول الكثير منهم شخصيّاتهم وسيرتهم بطريقةٍ مليئةٍ بالشيطَنة والخبث والتزوير، مُستترين بستار البحث والنقد العلميّين، خصوصاً أنّ الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وأهل بيته (عليهم السلام) رسموا تاريخ هذا الدين وترجموه في الواقع، حركةً تغييريّةً شاملة عملت على استئصال جذور الجاهليّة والظلم والانحراف، وأماطت اللثام عنها، وكشفت مواطن الحق مِن الباطن، وما هو لله منه وما هو للشيطان...لتُميّز البشريّة طريق الهُدى مِن طريق الضلال، لا من خلال المفاهيم والنظريّات فحسب؛ لأنّها قد لا تسلم من التحريف والتلبيس عند التطبيق، بل من خلال المصاديق المعصومة التي تكشف عن الإرادة الحقيقيّة لله سبحانه وتعالى في خطابه للبشريّة وتشريعاته لنُظم حياتهم وترشيد مسيرتهم نحو السعادة والكمال المطلق.
وكان محور محاولات المُستشرقين في تناول السيرة النبويّة هو إسقاط هذا الثقل في واقع المسلمين، منضمّاً إلى الثقل الأوّل وهو القرآن الكريم، وبذلك ينهار البناء الإسلامي بكلّ أبعاده الفكريّة والسياسيّة... ومن أجل ذلك راحوا يتتبّعون مفردات التاريخ الإسلامي؛ لاستقصاء موارد الشذوذ ومواطن التزوير في السيرة النبويّة، التي أحدثها وعّاظ
السلاطين ومرتزق الحكام المنحرفين، كخلفاء بني أُميّة وخلفاء بني العبّاس، وتسليط الضوء عليها إظهارها على أنّها السيرة الفعليّة للرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأهل بيته (عليهم السلام)، ثمّ يبدأ استثمار ذلك عند تأسيس بحثٍ نقدي لشخصيّة الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لتحقيق هدفين:
الأوّل: إبراز تهافت وتناقض في سيرته وصولاً لنفي نبوّته وعالميّته، وتقرير أنّه ليس إلاّ رجلُ إصلاحٍ قومي، استثمر النصرانيّة واليهوديّة وأمثالهما وأضاف إليها من عنده؛ لتنسجم مع مجتمعه وظرفه الزماني والمكاني.
والثاني: وصمُ السنّة النبويّة بالاختلاق والوضع، ومِن ثمّ الدعوة إلى عدم حجّيتها كمصدر أساسي من مصادر التشريع في الإسلام، ولم تكن هذه المُعطيات جزافاً، بل هي إفراز طبيعي للصراع المُحتدم بين الإسلام والصليبيّة، وقد كان للنتائج التي تمخّضت عنها الحروب الصليبيّة طعم العلقم في حلوق الأوربيّين لا ينسونه أبداً.
ويتحدّث الكاتب المسلم(ليوبولد فايس) - (محمّد أسد) - عن التجربة المُرّة التي استحالت مُعضلة في مناهجهم يصعب تجاوزها، فيقول:( فيما يتعلّق بالإسلام فإنّ الاحتقار التقليدي أخذ يتسلّل في شكل تحزّبٍ غير معقول على بحوثهم العلميّة، وبقي هذا الخليج الذي حفره التاريخ بين أوربّا والعالم الإسلامي - مُنذ الحروب الصليبيّة - غير معقودٍ فوقه جسر، ثمّ أصبح احتقار الإسلام جزءاً أساسيّاً في التفكير الأوربّي، والواقع أنّ المستشرقين الأوائل في الأعصر الحديثة كانوا مُبشّرين نصارى يعملون في البلاد الإسلاميّة، أمّا تحامل المستشرقين على الإسلام فغريزةٌ موروثة، وخاصّة طبيعيّة تقوم على المؤثّرات التي خلّفتها الحروب الصليبيّة بكلّ ما لها من ذيول في عقول الأوربيّين).
لقد كشفت أقلام الكثير من المستشرقين عن الحقد والغريزة العدائيّة الموروثة، تجاه الإسلام والمسلمين ونبيّهم نبيّ الرحمة محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، حتّى كالوا من الشتائم ما يربأ قلمنا عن تناوله، لو لا أنّنا بصدد تعريتهم وكشف مخطّطاتهم الخبيثة
التي تنسج تحت ستار العلم والمعرفة.
فهذا(المونيسنيور كولي) يقول في كتابه(البحث عن الدين الحق) : (برَز في الشرق عدوٌّ جديد هو الإسلام، الذي أُسّس على القوّة وقام على أشدّ أنواع التعصّب، ولقد وضع محمّدٌ السيف في أيدي الذين تبعوه وتساهل في أقدس قوانين الأخلاق، ثمّ سمح لأتباعه بالفجور والسلب، ووعَد الذين يهلكون في القتال بالاستمتاع الدائم بالملذّات في الجنّة، وبعد قليل أصبحت آسيا الصغرى وإفريقيا واسبانيا فريسةً له، حتّى ايطاليا هدّدها الخطر وتناول الاجتياح نصف فرنسا، لقد أُصيبت المدنية...
ولكن انظر: ها هي النصرانيّة تضع بسيف(شارل مارتل) سدّاً في وجه سيل الإسلام المُنتصر عند بوابّات(بواتييه) ثمّ تعمل الحروب الصليبيّة في مدى قرابة قرنين تقريباً (١٠٩٩ - ١٢٥٤م) في سبيل الدين، فتدجّج أوربّا بالسلاح وتنمّي النصرانيّة.
وهكذا تقهقرت قوّة الهلال أمام راية الصليب، وانتصر الإنجيل على القرآن، وعلى ما فيه من قوانين الأخلاق الساذجة).
أمّا(المسيو كيمون) فيقول في كتابه(ميثولوجيا الإسلام) : (إنّ الديانة المحمّديّة جذامٌ نشأ بين الناس وأخذ يفتك بهم فتكا ذريعاً، بل هو مرضٌ مروّع وشللٌ عام، وجنونٌ ذهولي يبعث الإنسان على الخمول والكسل، ولا يُوقظهُ منهما إلاّ ليسفك الدماء ويدمن معاقرة الخمور ويجمح في القبائح.
وما قبر محمّد في مكّة [!](١) إلاّ عموٌد كهربائي يبثّ الجنون في رؤوس المسلمين ويُلجئهم إلى الإتيان بمظاهر الصرع [الهستريا] والذهول العقلي، وتكرار لفظ (الله... الله...) إلى ما لا نهاية وتعوّد عادات تنقلب إلى طِباع أصيلة ككراهيّة لحم الخنزير، والنبيذ، والموسيقى، وترتيب ما يستنبط من أفكار القسوة والفجور في الملذّات).
____________________
(١) قبر رسول الإسلام محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في المدينة المنوّرة وليس في مكّة المكرّمة.
وتستمرّ أقلام الحقد الاستشراقي المُشبع بالدوافع التبشيريّة والاستعماريّة تسطّر - جزافاً - أوصافاً ومقولات رخيصة، بحقّ الرسول محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) دون مراعاةٍ لأيّ حقيقة تاريخيّة، أو قاعدة من قواعد الطرح العلمي، فقد كتب الدكتور(غلاوو) في نهاية الباب الرابع من كتابه(تقدّم التبشير العالمي) الذي نشره في نيويورك سنة ١٩٦٠م:( إنّ سيف محمّد والقرآن أشدّ عدوٍّ وأكبرُ معاندٍ للحضارة والحريّة والحق، ومن العوامل الهدّامة التي اطّلع عليها العالم إلى الآن).
ويستمرّ في نقدهِ الوضيع لشخصيّة الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فيقول:( كان محمّدٌ حاكماً مطلقاً، وكان يعتقد أنّ من حقّ الملك على الشعب أنْ يتبع هواه ويفعل ما يشاء، وكان مجبولاً على هذهِ الفكرة، فقد كان عازماً على أنْ يقطع عنق كلّ من لا يوافقه في هواه، أما جيشه العربي فكان يتعطش للتهديم والتغلب، وقد أرشدهم رسولهم أنْ يقتلوا كلّ من يرفض اتّباعهم ويبعد عن طريقهم)! .
أمّا(سفاري) الذي ترجم معاني القرآن سنة (١٧٥٢م)، فيعتقد( أنّ محمّداً لجأ إلى السلطة الإلهية لكي يدفع الناس إلى قبول هذهِ العقيدة، ومن هنا طالب بالإيمان به كرسول الله، وقد كان هذا اعتقاداً مزيّفاً أملته الحاجة العقليّة...) . وبنفس المنطق يقول (جويليان) في كتابه (تاريخ فرنسا):
(إنّ محمّداً، مؤسّس دين المسلمين، قد أمر أتباعه أنْ يُخضعوا العالم وأنْ يبدلّوا جميع الأديان بدينه هو،....ماذا كان حال العالم لو أنّ العرب انتصروا علينا؟ إذن لكنّا مسلمين كالجزائريّين والمراكشيّين).
وعلى نفس المنوال كانت كتاباتهم عن أئمّة أهل بيت النبوّة (عليهم السلام)، نذكر أدناه نماذج منها: منها ما أورده المستشرق (تسترشتين K. V. Zettersteen ) عن (ابن تيمية) في دائرة المعارف الإسلاميّة تحت مادّة (ابن تيمية) طعناً في عصمة الإمام
عليّ (عليه السلام)، من (أنّ عليّ بن أبي طالب أخطأ ثلثمِئة مرّة)(١) .
وبهدف الانتقاص والنيل من شخصيّة ومقام الإمام الحسن (عليه السلام)، توالت افتراءات العديد من المستشرقين في اتّهام الإمام الحسن (عليه السلام)، واختلاق الأكاذيب حول أخلاقه الشخصيّة وسيرته ومواقفه الرساليّة، وعلى رأسها إبرام الشبهات حول حقيقة صلحه مع معاوية بن أبي سفيان.
وكان في مقدّمة هؤلاء المستشرقين (بروكلمان) و(راويت رونلدسن) و(هوكلي) و(ساكيس).
على أنّ أكثرهم افتراءً ودسّاً وتحاملاً، حاقداً فيما قال هو المستشرق (لامنس H. Lammens ) المعروف بعدائه للإسلام وحقده على رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأهل بيته الطاهرين (عليهم السلام)، ومن مفترياته المليئة بالعبارات التجديفيّة، الكاشفة عن سقوط منهجه العلمي إلى حضيض السبِّ والشتائم الرخيصة، ما جاء تحت مادّة(الحسن) بن عليّ بن أبي طالب، الذي خالف فيه بشكلٍ فاضحٍ المعقولَ والمنقولَ من ثوابت التاريخ الإسلامي في حقّ الإمام الحسن (عليه السلام).
كقوله: (... إنّ الصفات الجوهريّة التي كان يتّصف بها الحسن هي الميل إلى الشهوات، والافتقار إلى النشاط والذكاء، ولم يكن الحسن على وفاق مع أبيه وإخوته، وقد انفق خير سنيّ شبابه في الزواج والطلاق، فأُحصيَ له حوالي المِئة زيجة عدّاً، وأُلصِقَت به هذه الأخلاق السائبة لقب المِطلاق، وأوقعت عليّا في خصومات عنيفة.
وأثبت الحسن كذلك أنّه مبذّر كثير السرَف، فقد اختصّ كلاً من زوجاته بمَسكن ذي خدم وحشم، وهكذا ترى كيف كان يُبعثر المال أيّام خلافة عليّ التي اشتدّ عليها الفقر، وشهد يوم صفّين دون أنْ تكون له فيها مشاركة ايجابيّة، ثمّ هو إلى ذلك لم يهتمّ أيّ اهتمام بالشؤون العامّة في حياة أبيه.
____________________
(١) دائرة المعارف الإسلاميّة: ١: ١١٢.
وبُويع الحسن بالخلافة في العراق بعد مقتل عليّ فحاول أنصاره أنْ يقنعوه بالعودة إلى قتال أهل الشام، وقلب هذا الإلحاح من جانبهم خطط الحسن القعيد الهمّة، فلم يعد يفكّر إلاّ في التفاهم مع معاوية كما أدّى إلى وقوع الفرقة بينه وبين أهل العراق، وانتهى بهم الأمر إلى إثخان إمامهم اسماً لا فعلاً بالجراح، فتملّكت الحسن مُنذ ذلك الوقت فكرةٌ واحدة هي الوصول إلى اتّفاق مع الأُمويّين.
وترك له معاوية أنْ يحدّد ما يطلبه جزاء تنازله عن الخلافة، ولم يكتف الحسن بالمليونَيّ درهم التي طلبها معاشاً لأخيه الحسين، بل طلب لنفسه خمسة ملايين درهم أُخرى ودخل كورة في فارس طيلة حياته، وعارض أهل العراق بعد ذلك في تنفيذ الفقرة الأخيرة من هذا الاتّفاق، بَيد أنّه أُجيب إلى كلّ ما سأله حتّى أنّ حفيد النبيّ اجترأ فجاهر بالندم، على أنّه لم يُضاعف طلبه، وترك العراق مشيّعاً بسخط الناس عليه ليقبع في المدينة.
وهناك عاد إلى حياة اللهو واستسلم للملذّات، ووافق معاوية على أنْ يدفع نفقاته ولم يطلب في مقابل ذلك إلا أمراً واحداً، هو ألا يخلّ الحسنُ بأمن الدولة، وكان قد أجبره من قبل على الجهر بتنازله عن الخلافة في اجتماعٍ عُقِد في(أذرح) ولم يعد معاوية يشغل باله به، ذلك أنّه كان واثقاً من قُعود همّته وإيثاره للدِعة.
ومع هذا فقد استمرّ الانقسام في البيت العلوي، ولم يكن الحسن على وفاق مع الحسين وإنْ اجتمعا على مناهضة ابن الحنفيّة وغيره من أبناء عليّ.
وتوفّي الحسن في المدينة بذات الرئة، ولعلّ إفراطه في الملذّات هو الذي عجّل بمنيّته. وقد بُذلت محاولة لإلقاء تبعة موته على رأس معاوية، وكان الغرض من هذا الاتّهام وصم الأمويّين بهذا العار، وتبرير لقب الشهيد أو (سيّد الشهداء) الذي
خُلِع على ابن فاطمة هذا...(١) . ولم يجرؤ على القول بهذا الاتّهام الشنيع جهرةً سِوى المؤلّفين من الشيعة، أو أولئك الذين كان هواهم مع العلويّة بنوعٍ خاص، وقد أعطى هذا الاتّهام في الوقت نفسه فرصة للإيقاع بأسرة الأشعث بن قيس المُبغضة من الشيعة، لما كان لها من شأن في الانقلاب الذي حدث يوم صفّين، وما كان معاوية بالرجل الذي يقترف إثماً لا مبرّر له.
كما أنّ الحسن كان قد أصبح مسالماً منذ أمدٍ طويل، وكانت حياته عبئاً على بيت المال الذي أبهظته مطالبه المتكرّرة، ومن اليسير أنْ نعلّل ارتياح معاوية وتنفّسه الصعداء عندما سمِع بمرضِ الحسن)(٢) .
ومن أقوالهم وآرائهم لجزافيّة التي تكشف عن سطحيّة معلوماتهم وعدم استقصائهم لحقائق تاريخ أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) ما أورده (تسترشتين K. V. Zettersteen ) في دائرة المعارف الإسلاميّة تحت مادّة(جعفر) بقوله:( جعفر بن محمّد، ويلقّب أيضاً بالصادق، سادس الأئمّة ألاثني عشريّة.. وخلف في الإمامة أباه محمّداً الباقر، ولم يكن له شأن في عالم السياسة، ولكنّه عُرِف بدرايته الواسعة بالحديث، ويُقال أيضاً: إنّه اشتغل بالتنجيم والكيمياء وغيرهما من العلوم الخفيّة، أمّا المؤلّفات التي تحمل اسمه فقد دُسّت عليه فيما بعد...)(٣) .
بهذا المنهج وبهذه الروح المُتعصّبة، تناولوا شخصيّة الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأهل بيته (عليهم السلام) وسيرتهم، فكانت المعطيات رؤىً واستنتاجات ما أنزل الله بها من سلطان، يصوّرونها وكأنّها حقائقٌ ثابتة ويقينٌ راسخ، رغم أنّها بُنيت أساساً على الوهم الذي تستحيل معهُ رؤية الحقائق بحجمها الطبيعي؛ لأنّها انبثقت عن زاوية
____________________
(١) اعرضنا عن ذكر هذا المحذوف لما فيه من إساءة فاحشة بحقّ الإمام الحسن (عليه السلام) لا يليق بنا إيرادها.
(٢) دائرة المعارف الإسلاميّة: ٧: ٤٠٠.
(٣) دائرة المعارف الإسلاميّة: ٦: ٤٧٣.
ضيّقة مترعة بالتعصّب، ونظر إليها من خلال خلفيّة سلبيّة مُسبقة، جعلت منهم ينتقون لبناء نظريّتهم عن الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وأهل بيته (عليهم السلام) الشاذّ الغريب ممّا نُقِل عنهم صلوات الله عليهم، بل واختلاق الأكاذيب والافتراءات عليهم.
ويُمكننا وضع اليد على الكثير من مصاديق ذلك في كتاباتهم ومؤلّفاتهم، ونكتفي بالإشارة لأهمّ أنماط هذه المصاديق المُنحرفة، التي تضمّنتها نظريّتهم عن الرسول محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأهل بيته (عليهم السلام):
أولاً: تتبّع الشاذّ والضعيف من الأخبار الواردة عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وأهل بيته (عليهم السلام) وعن سيرتهم وتاريخهم: وهذه الأخبار غالباً ما تكون من تلك التي عُرِفت بالإسرائيليّات، أو من الموضوعات في ظلّ الحكومات التي كانت تُعادي أهل بيت النبوّة (عليهم السلام)، وبإبرازها دون المشهور والموثوق منها؛ لكي يتمّ لهم الأساس الذي يبنون عليه نظريّتهم عن سيرة الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأهل بيته (عليهم السلام).
وبهذا الصدد يقول (جواد عليّ) في كتابه (تاريخ العرب في الإسلام): (لقد أخذ المستشرقون بالخبر الضعيف والموضوع في بعض الأحيان وحكموا بموجبه واستعانوا بالشاذّ والغريب، فقدموه على المعروف والمشهور)(١) ، وقد مهّد لذلك قيام بعضهم بإصدار كتب عن السنّة النبويّة، ومعاجم مفهرسة لألفاظ الحديث دُسّت فيها الأخبار والتقارير الشاذّة والمردودة ضمن سياق الصحيح، لتسوغ معها ويختلط أمرها فيعتمد القارئ أو الباحث عليها على أنّها من السنّة النبويّة، كما فعلهُ المستشرق(فينسنك) في كتابه(كنوز السنّة) ومعجمهِ المفهرس لألفاظ الحديث.
ومن ذلك نقلهم للروايات الكاذبة حول زوجات الإمام الحسن بن عليّ بن أبي طالب (عليهما السلام) كرواية (السبعين والتسعين، وغيرها من الروايات التي تصف
____________________
(١) عليّ، جواد - (تاريخ العرب في الإسلام) - الجزء الأوّل - ص٨ - ١١ من موضوع (السيرة النبويّة).
الإمام الحسن (عليه السلام) بأنّه مطلاق، وأنّ والده كان يقول: لا تزوّجوا ولدي الحسن فإنّه مطلاق، فلا مصدر لها، إلاّ المدائني وأمثاله من الكَذَبة كما يبدو من أسانيدها، والمدائني والواقدي وغيرهما من المؤرّخين القدامى قد كتبوا التاريخ في ظلّ الحكومات التي كانت تناهض أهل البيت، وتعمل بكلّ ما لديها من الوسائل على تشويه واقعهم وانتقاصهم، ولم يكن حكّام الدولة العباسيّة بأقلّ سوءاً وتعصّباً من أسلافهم الأمويّين، فقد شاركوهم في وضع الأحاديث التي تسيء إلى العلويّين، وكانوا يحقدون على الحسنَين بصورةٍ خاصّة؛ لأنّ أكثر الثائرين على الظلم كانوا من أولاد الحسن وأحفاده.
وعلى ما يبدو أنّ الذين ألصقوا بالحسن كثرة الزواج والطلاق هؤلاء الثلاثة: المدائني، والشبلنجي، وأبو طالب المكّي في قوت القلوب، وعنهم أخذَ المستشرقون، أمّا عليّ بن عبد الله البصري المعروف بالمدائني، والمُعاصر للعباسيّين فهو من المتّهمين بالكذِب في الحديث.
وجاء في ميزان الاعتدال للذهبي أنّ مسلماً في صحيحه قد امتنع عن الرواية عنه، وأنّ ابن عدِي قد ضعّفه، وقال له الأصمعي: والله لتتركنّ الإسلام وراء ظهرك، وكان من خاصّة أبي إسحاق الموصلي، وقد تبعه لثرائه، ويروي عن عوانة بن الحكم المتوفّى سنة ١٥٨ والمعروف بولائه لعثمان والأمويّين.
ونصّ ابن حجر في لسان الميزان أنّ عوانة كان يضع الأخبار لبني أميّة، وجاء في معجم الأُدباء أنّه كان مولى لسمرة بن حبيب الأموي، أمّا صاحب لسان الميزان فقد قال: إنّه كان مولىً لعبد الرحمان بن سمرة بن حبيب الأموي، هذا بالإضافة إلى أنّ أكثر رواياته من نوع المراسيل، كلّ ذلك ممّا يبعث على الاطمئنان بأنّ رواية السبعين، التي لم يروِها غير المدائني من موضوعاته لمصلحة الحاكمين أعداء العلويّين.
أمّا رواية التسعين فقد أرسلها الشبلنجي في كتابه نور الأبصار ولم ينسبها لأحد، والشبلنجي في كتابه المذكور لم يتحرّ الصحيح في مرويّاته وأخباره كما يبدو ذلك للمتتبّع فيه، والمرسل إذا لم يكن مدعوما بشاهد من الخارج أو الداخل لا يصلح للاستدلال، في حين أنّ الشواهد والقرائن ترجّح بأنّه من صنع الحاقدين على أهل البيت.
وأمّا رواية المكّي في قوت القلوب فهي أقرب إلى الأساطير من غيرها؛ لأنّها لم ترد على لسان أحدٍ من الرواة، وأبو طالب المكّي كان مصابا بالهستيريا كما نص على ذلك معاصروه، وحينما وفد على بغداد وجد البغداديون في حديثه هذياناً وخروجاً عن ميزان الاعتدال والاستقامة)(١) .
ومثله ما ألصقوه، على أساس الروايات الشاذّة والمختلقة، من تهم شنيعة وشُبهاتٌ ظالمة للإمام الحسن (عليه السلام)، حول صلحه مع معاوية بن أبي سفيان، وقد ردّ عليها علماءُ مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) وكثير من المفكّرين الإسلاميّين والمنصفين من أهل العلم والتخصّص، ومن أبرزهم العلاّمة المحقّق الإمام السيّد(عبد الحسين شرف الدين الموسوي) في مقدّمته لكتاب(صلح الحسن) للشيخ راضي آل ياسين، التي جاء فيها:
( .. نشَط معاوية في عهد الخليفتين الثاني والثالث، بإمارته على الشام عشرين سنة، تمكّن بها في أجهزة الدولة، وصانع الناس فيها وأطمعهم به فكانت الخاصّة في الشام كلّها مِن أعوانه، وعظم خطره في الإسلام، وعُرِف في سائر الأقطار بكونه مِن قُريش - أسرة النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) - وأنّه من أصحابه، حتّى كان - في هذا - أشهر من كثير من السابقين الأوّلين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، كأبي ذر وعمّار والمقداد وأضرابهم).
____________________
(١) الحسني، هاشم معروف - سيرة الأئمّة الاثني عشر - ١: ٥٥٤ - ٥٥٧.
هكذا نشأت (الأمويّة) مرّة أُخرى، تغالب الهاشميّة باسم الهاشميّة في علنها، وتكيد لها كيدها في سرّها، فتندفع مع انطلاق الزمن تخدع العامّة بدهائها، وتشتري الخاصّة بما تغدقه عليه من أموال الأمّة، وبما تؤثرهم به من الوظائف التي ما جعلها الله للخوَنة مِن أمثالهم، وتستغلّ مظاهر الفتح وإحراز الرضا من الخلفاء.
حتّى إذا استتب أمر (الأمويّة) بدهاء معاوية، انسلّت إلى أحكام الدين انسلال الشياطين، تدسّ فيها دسّها، وتفسد إفسادها، راجعة بالحياة إلى جاهليّة تبعث الاستهتار والزندقة، وفق نهجٍ جاهلي، وخطّة نفعيّة، ترجوها (الأمويّة) لاستيفاء منافعها، وتستخرها لحفظ امتيازاتها.
والناس - عامّة - لا يفطنون لشيء من هذا، فإنّ القاعدة المعمول بها في الإسلام - أعني قولهم: الإسلام يجبّ ما قبله - ألقت على فظائع (الأمويّة) ستراً حجبها، ولا سيّما بعد أنْ عفا عنها رسول الله وتألفها، وبعد أنْ قرّبها الخلفاء منهم، واصطفوها بالولايات على المسلمين، وأعطوها من الصلاحيّات ما لم يعطوا غيرها من ولاتهم، فسارت في الشام سيرتها عشرين عاما ( ..لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ.... ) ولا ينهون.
وهذا ما أطغى معاوية، وأرهف عزمه على تنفيذ خططه (الأمويّة)، وقد وقف الحسن والحسين من دهائه ومكره إزاء خطرٍ فظيع، يهدّد الإسلام باسم الإسلام، ويطغى على نور الحقّ باسم الحق، فكانا في دفع هذا الخطر أمام أمرين لا ثالث لهما: إمّا المقاومة، وإمّا المسالمة.
وقد رأيا أنّ المقاومة في دور الحسن تؤدّي لا محالة إلى فناء هذا الصفّ المدافع عن الدين وأهله، والهادي إلى الله عزّ وجل، وإلى صراطه المستقيم، إذ لو غامر الحسن يومئذٍ بنفسه وبالهاشميّن وأوليائهم، فواجه بهم القوّة التي لا قِبل لهم بها مصمّما على التضحية، تصميم أخيه يوم(الطف)
لانكشفت المعركة عن قتلهم جميعاً، ولانتصرت (الأمويّة) بذلك نصراً تعجز عنه إمكانيّاتها، ولا تنحسر عن مثله أحلامها وأُمنياتها، إذ يخلو بعدهم لها الميدان، تمعن في تَيهها كلّ إمعان، وبهذا يكون الحسن - وحاشاه - قد وقع فيما فرّ منه على أقبح الوجوه، ولا يكون لتضحيته أثر لدى الرأي العام إلاّ التنديد والتفنيد؛ لأنّ معاوية كان يطلب الصلح ملحّا على الحسن بذلك، وكان يبذل له من الشروط لله تعالى وللأُمّة كلّ ما يشاء، يناشده الله في حقن دماء أمّة جدّه.
وقد أعلن طلبه هذا فعلمه المعسكران، مع أنّ الغلبة كانت في جانبه لو استمرّ القتال، يعلم ذلك الحسن ومعاوية وجنودهما، فلو أصرّ الحسن - والحال هذه - على القتال، ثمّ كانت العاقبة عليه لعذله العاذلون وقالوا فيه ما يشاؤون.
ولو اعتذر الحسن يومئذٍ بأنّ معاوية لا يفي بشرط، ولا هو بمأمون على الدين ولا على الأمّة، لمَا قَبل العامّة يومئذٍ عذره، إذ كانت مغرورة بمعاوية كما أوضحناه، ولم تكن الأمويّة يومئذٍ سافرة بعيوبها سفوراً بيّناً بما يؤيّد الحسن أو يخذل معاوية، لاغترار الناس بمعاوية وبمكانته من أُولي الأمر الأوّلين، لكنْ انكشف الغطاء، في دور سيّد الشهداء فكان لتضحيته (عليه السلام) من نصرة الحق وأوليائه آثاره الخالدة.
ومن هنا رأى الحسن (عليه السلام) أنْ يترك معاوية لطغيانه، ويمتحنه بما يصبو إليه من الملك، لكن أخذ عليه في عقد الصلح، أنْ لا يعدو الكتاب والسنّة في شيء من سيرته وسيرة أعوانه ومقوّية سلطانه، وأنْ لا يطلب أحداً من الشيعة بذنبٍ أذنبه مع الأموية، وأنْ يكون لهم من الكرامة وسائر الحقوق ما لغيرهم من المسلمين، وأنْ، وأنْ، وأنْ. إلى غير ذلك من الشروط التي كان الحسن عالماً بأنّ معاوية لا يفي له بشيء منها، وأنّه سيقوم بنقائضها.
هذا ما أعدّه (عليه السلام) لرفع الغطاء عن الوجه (الأموي) المموّه، ولصَهر الطلاء
عن مظاهر معاوية الزائفة، ليبرز حينئذٍ هو وسائر أبطال (الأمويّة) كما هُم جاهليّين، لم تخفق صدورهم بروح الإسلام لحظة، ثأريّين لم تُنسِهم مواهب الإسلام ومراحمه شيئاً من أحقادِ بدرٍ وأُحد والأحزاب.
وبالجملة فإنّ هذه الخطّة ثورةٌ عاصفة في سلمٍ لم يكن منه بُد، أملاه ظرفُ الحسن، إذ التبس فيه الحقّ بالباطل، وتسنّى للطغيان فيه سيطرةٌ مسلّحةٌ ضارية.
وما كان الحسن ببادئ هذه الخطّة ولا بخاتمها، بل أخذها فيما أخذه من إرثه، وتركها مع ما تركه من ميراثه، فهو كغيره من أئمّة هذا البيت، يسترشد الرسالة في إقدامه وفي إحجامه، امتُحن بهذهِ الخطّة فرضَخ لها صابراً محتسباً وخرجَ منها ظافراً طاهراً، لم تُنجّسه الجاهليّة بأنجاسها، ولم تُلبسه من مُدلهمّات ثيابها.
أخذ هذه الخطّة من صلح (الحديبيّة) فيما أثَر من سياسة جدّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وله فيه أسوةٌ حسنة، إذ أنكر عليه بعضُ الخاصّة مِن أصحابه كما أنكر على الحسن صُلح (ساباط) بعض الخاصّة من أوليائه، فلم يهن بذلك عزمه، ولا ضاق به ذرعه.
تهيّأ للحسن بهذا الصلح أنْ يَغرس في طريق معاوية كميناً من نفسه، يثور عليه من حيث لا يشعر فيُرديه، وتسنّى له به أْن يلغم نصر الأمويّة ببارود الأمويّة نفسها، فيجعل نصرها جفاء، وريحا هباء.
لم يطل الوقت حتّى انفجرت أُولى القنابل المغروسة في شروط الصلح، انفجرت من نفس معاوية يوم نشوته بنصره، إذ انضم جيش العراق إلى لوائه في النخيلة، فقال - وقد قام خطيباً فيهم -:( يا أهل العراق، إنّي والله لم أُقاتلكم لتصلّوا ولا لتصوموا، ولا لتزكّوا، ولا لتحجّوا، وإنّما قاتلتكم لأتأمّر عليكم، وقد أعطاني الله ذلك وانتم كارهون.
ألا وأنّ كلّ شيء أعطيته للحسن بن عليّ جعلته تحتَ قدمَيَّ هاتين!) .
فلمّا تمّت له البيعة خطب فذكر عليّاً فنال منه، ونال من الحسن، فقام الحسين
ليردّ عليه، فقال له الحسن:(على رسلك يا أخي) .
ثمّ قال (عليه السلام) فقال:(أيها الذاكر عليّاً! أنا الحسنُ وأبي عليّ، وأنتَ معاوية وأبوك صخر، وأُمّي فاطمة وأُمّك هند، وجدّي رسولُ الله وجدّك عتبة، وجدّتي خديجة وجدّتك فتيلة، فلعنَ الله أخملنا ذكراً وألأَمَنا حسباً، وشرّنا قديماً، وأقدمنا كفراً ونفاقاً!).
فقالت طوائف من أهل المسجد: (آمين).
ثمً تتابعت سياسة معاوية، تتفجّر بكلّ ما يُخالف الكتاب والسنة مِن كلّ منكرٍ في الإسلام، قتلاً للأبرار، وهتكاً للأعراض، وسلباً للأموال، وسجناً للأحرار، وتشريداً للمصلحين، وتأييداً للمفسدين الذين جعلهم وزراء دولته، كابن العاص، وابن شعبة، وابن سعيد، وابن ارطاة، وابن جندب، وابن السمط، وابن الحكَم، وابن مرجانة، وابن عقبة، وابن سميّة الذي نفاه عن أبيه الشرعي عبيد، وألحقه بالمسافح أبيه أبي سفيان ليجعله بذلك أخاه، يسلّطه على الشيعة في العراق، يسومهم سوء العذاب، يذبّح أبناءهم، ويستَحيي نساءهم، ويفرّقهم عباديد، تحت كلّ كوكب، ويحرق بيوتهم، ويصطفي أموالهم، لا يألو جهداً في ظلمهم بكلّ طريق.
ختم معاوية منكراته هذه بحمل خليعه المهتوك على رقاب المسلمين، يعيث في دينهم ودنياهم، فكان من خليعه ما كان يوم الطف، ويوم الحرّة، ويوم مكّة إذ نصب عليها العرادات والمجانيق!.
هذه خاتمة أعمال معاوية، وإنّها لتلائم كلّ الملاءمة فاتحة أعماله القاتمة.
ومهما يكن من أمر، فالمهم أنّ الحوادث جاءت تفسيرَ خطّة الحسن وتجلوها، وكان أهمّ ما يرمي إليه سلام الله عليه، أنْ يرفع اللثام عن هؤلاء الطغاة، ليحوّل بينهم وبين ما يبيتون لرسالة جدّه من الكيد.
وقد تمّ له كلّ ما أراد، حتّى برح الخفاء، وآذن أمر الأمويّة بالجلاء.
وبهذا استتب لصنوه سيّد الشهداء أنْ يثور ثورته التي أوضح الله بها الكتاب، وجعله فيها عبرة لأولي الألباب.
وقد كانا (عليهما السلام) وجهين لرسالة واحدة، كلّ وجه منهما في موضعه منها، وفي زمانه من مراحلها، يكافئ الآخر في النهوض بأعبائها ويوازنه بالتضحية في سبيلها.
فالحسن لم يبخل بنفسه، ولم يكن الحسين أسخى منه بها في سبيل الله، وإنّما صان نفسه، ويجنّدها في جهادٍ صامت، فلمّا حان الوقت كانت شهادة كربلاء شهادة حسنيّة، قبل أنْ تكون حسينيّة.
وكانا (عليهما السلام) كأنّهما متّفقان على تصميم الخطّة: أنْ يكون للحسن منها دورَ الصابر الحكيم، وللحسين دور الثائر الكريم، لتتألّف من الدورين خطّة كاملة ذاتَ غرضٍ واحد.
وقد وقف الناس - بعد حادثتَي ساباط والطف - يمعنون في الأحداث فيَرَون في هؤلاء الأمويّين عصبةً جاهليّةً منكرة، بحيث لو مثّلت العصبيّات الجلفة النذلة الظلُوم لم تكن غيرهم، بل تكون دونهم في الخطر على الإسلام وأهله.
نعم أدرك الرأي العام بفضل الحسن والحسين وحكمة تدبيرهما، كلّ خافيةٍ من أمر (الأمويّة) وأُمور مسدّدي سهمها على نحوٍ واضح.
أدرك - فيما يتّصل بالأمويّين - أنّ العلاقة بينهم وبين الإسلام إنّما هي علاقة عِداءٍ مُستحكَم، ضرورة أنّه إذا كان المُلك هو ما تَهدِف إليه الأمويّة، فقد بلغه معاوية، وأتاحه له الحسن، فما بالها تلاحقه بالسمّ وأنواع الظلم والهضم، وتتقصّى الأحرار الأبرار من أوليائه لتستأصل شأفتهم وتقتلع بذرتهم؟!..
وإذا كان المُلك وحده هو ما تهدف إليه الأمويّة، فقد أُزيح الحسين من الطريق، وتمّ ليزيد ما يُريد، فما بالها لا تكفّ ولا ترعوي، وإنّما تُسرف أقسى ما
يكون الإسراف والإجحاف في حركةٍ من حركات الإفناء على نمطٍ من الاستهتار، لا يُعهد في تاريخ الجزّارين والبرابرة!!..)(١) .
ثانياً: ردّ سيرة الرسول محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ومعطياتها إلى أُصول نصرانيّة أو يهوديّة: فقد كتب المُستشرق(درمنغهام) في ذلك قائلاً: (إنّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في إحدى الرحلات إلى الشام، التقى بالراهب بُحيرى في جوار مدينة بُصرى، وإنّ الراهب رأى فيه علامات النبوّة على ما تدلّه عليه أنباء الكُتب الدينيّة. وفي الشام عرفَ محمّد أخبار الروم ونصرانيّتهم وكتابهم، ومناوأة الفرس من عبّاد النار لهم وانتظار الوقيعة بهم).
ويستطرد درمنغهام في محاولته لإثبات تأثير النصرانيّة على سيرة الرسول محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فيقول: (... لم تكن المضاربات الجدليّة لتصرفه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عن التأثر بغير الحوادث ودروسها، وحوادثٌ أليمةٌ - كَوفاة أبنائه - جديرةٌ بأنْ تستوقف تفكيرهُ، وأنْ تصرفه كلّ واحدةٍ منها إلى ما كانت خديجة تتقرّب به إلى أصنام الكعبة، وتنحر لهُبَل واللات والعزّى ومناة الثالثة الأُخرى، تريد أنْ تفتدي نفسها من ألم الثكل، فلا يفيد القربان ولا تجدي النحور...
لا ريب إنْ كانت عبادة الأصنام قد بدأت تتزعزع في النفوس، تحت ضغط النصرانيّة الآتية من الشام مُنحدرةً إليها من الروم، ومن اليمن، متخطّية إليها من خليج العرب (البحر الاحمر من بلاد الحبشة). ويستمرّ درمنغهام في نظريّته لتنصير سيرة الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في قومه فيقول: (... فلمّا كانت سنة ٦١٠م أو نحوها كانت الحالة النفسيّة التي يُعانيها محمّد على أشدّها، فقد أبهظت عاتقهُ العقيدة بأنّ أمراً جوهريّاً ينقصهُ وينقص قومه، وأنّ الناس نَسوا هذا الأمر الجوهري، وتشبّث كلٌ بصنم قومهِ وقبيلته، وخشيَ الناس الجنّ
____________________
(١) لمزيد من التفصيل في أسرار صلح الإمام الحسن (عليه السلام) راجع: آل ياسين، الإمام الشيخ راضي - صلح الحسن (عليه السلام).
والأشباح والبوارح، وأهملوا الحقيقة العليا، ولعلّهم لم ينكروها، ولكنّهم نسوها نسياناً هو موت الروح... ولقد عرف أنّ المسيحيّين في الشام ومكّة لهم دين أُوحيَ به (!) وأنّ أقواماً غيرهم نزلت عليهم كلمة الله، وأنّهم عرفوا الحقّ ووَعَوه أنْ جاءهم علم من أنبيّاء أُوحي إليهم به، وكلّما ضلّ الناس بعثت السماء إليهم نبيّاً يهديهم إلى الصراط المستقيم، ويذكرهم بالحقيقة الخالدة.
وهذا الدين الذي جاء بهِ الأنبياء في كلّ الأزمان دين واحد، فكلّما أفسده الناس جاءهم رسول من السماء يقوّم عوجهم، وقد كان الشعب العربي يومئذٍ في أشدّ تيهاء الضلال، أما آن لرحمة الله أنْ تظهر فيهم مرّة أُخرى وأنْ تهديهم إلى الحق؟)(١) .
ويتحدّث عن هذا التزوير للحقائق التاريخيّة الأُستاذ جواد عليّ قائلاً:( إنّ معظم المستشرقين النصارى هُم مِن طبقة رجال الدين، أو ممّن تخرّج من كليّات اللاهوت، وهُم عندما يتطرّقون إلى الموضوعات الحسّاسة من الإسلام يُحاولون جهد إمكانهم ردّها إلى أصل نصراني. وطائفة المستشرقين من اليهود يُجهدون أنفسهم لردّ كل ما هو إسلامي وعربي لأصلٍ يهودي، وكلتا الطائفتين في هذا الباب تبع لسلطان العواطف والأهواء)(٢) .
وفي كتابٍ آخر عمل مستشرق وهو قسّيس انجليكاني على عقد عدّة مقارنات ليظهر إن الإسلام كان حقّاً صورة غير محكمة أو مشوهة للنصرانيّة(٣) .
ثالثاً: اعتماد منهج كيفي مناقض للمنهج العلمي في تناول السيرة الشريفة للرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأهل بيته (عليهم السلام): وإلى ذلك أشار الدكتور جواد عليّ من أنْ (كيناني)
____________________
(١) درمنغهام، أميل - (حياة محمّد) عن رشيد رضا، محمّد (الوحي المحمّدي) ص١٠٠ - ص١٠٨.
(٢) علي، جواد - (تاريخ العرب في الإسلام) - الجزء الأوّل (السيرة النبويّة) ص٩ - ١١.
(٣) د. خليل، عماد الدين - (المستشرقون والسيرة النبويّة) - مجلّة منار الإسلام العدد ٧.
وهو من كِبار المستشرقين الأوائل الذين كتبوا عن حياة محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، كان يعتمد منهجاً معكوساً في البحث يذكّرنا بكثير من المختصّين الجُدد في حقل التاريخ الإسلامي، والذين يعملون وفْق منهج خاطئ من أساسه، إذ أنّهم يتبنّون فكرة مُسبقة ثمّ يجيئون إلى وقائع التاريخ لكي يستلّوا منها ما يؤيّد فكرتهم ويستبعدوا ما دون ذلك، فلقد كان (كيناني) ذا رأيٍ وفكرة، وضع رأيه وكونه في السيرة قبل الشروع في تدوينها.
فلمّا شرع فيها استعان بكلّ خبر من الأخبار ظفر به، ضعيفها وقويّها، وتمسّك بها كلّها ولا سيما ما يُلائم رأيه. لم يُبال بالخبر الضعيف، بل قوّاه وسنده وعدّه حجّة وبنى حكمه عليه، ومَن يدري فلعلّه كان يعلم بسلاسل الكذِب المشهورة والمعروفة عند العلماء، ولكنّه عفا عنها وغضَّ نظره عن أقوال أولئك العلماء فيها؛ لأنّه صاحب فكرة يريد إثباتها بأيّة طريقةٍ كانت، وكيف يتمكّن من إثباتها وإظهارها وتدوينها، إذا ترك تلك الروايات وعالجها معالجةَ نقدٍ وجرحٍ وتعديل على أساليب البحث الحديث؟)(١) .
وأشار أيضاً(ايتين القيم) إلى بعض الآراء حول هذا المنهج قائلاً: (لقد أصاب الدكتور سنوك هرمزونية بقوله:
(إنّ سيرة محمّد الحديثة تدلّ على أنّ البحوث التاريخيّة مقضيٌّ عليها بالعقم، إذا سُخّرت لأيّه نظريّةٍ أو رأيٍ سابق). هذه حقيقة يَجمل بمستشرقيّ العصر جميعاً أنْ يضعوها نصب أعينِهم، فإنّها تشفيهم من داء الأحكام السابقة، التي تكلّفهم من الجهود ما يُجاوز حدّ الطاقة فيصلون إلى نتائج لا شكّ خاطئة، فقد يحتاجون في تأييد رأيٍ من الآراء إلى هدم بعض الأخبار وليس هذا بالأمر الهيّن، ثمّ إلى بناء أخبار تقوم مقام ما هدموا، وهذا أمرٌ لا ريب مستحيل.
إنّ العالم في القرن العشرين يحتاج إلى معرفة كثير من العوامل
____________________
(١) علي، جواد - (تاريخ العرب في الإسلام) - الجزء الأوّل (السيرة النبويّة) ص٩٥.
الجوهريّة، كالزمن والبيئة والإقليم والعادات والحاجات والمطامع والميول إلى آخره، لا سيّما إدراك تلك القُوى الباطنة، التي لا تقع تحت مقاييس المعقول والتي يعمل بتأثيرها الأفراد والجماعات)(١) .
وهناك المئات من مفردات المنهج الكيفي والتفسير على ضوء المسبقات والخلفيّات الخاصّة للنصوص التاريخيّة، في العديد من مؤلّفات وكتابات المستشرقين خصوصاً الأوائل منهم، فمثلاً (بروكلمان)(٢) ، لا يشير إلى دور اليهود في تأليب الأحزاب على المدينة ولا إلى نقض بني قريظة عهدها مع الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، في أشدّ ساعات محنته، لكنّه يقول: (ثمّ هاجم المسلمون بني قريظة الذين كان سلوكهم غامضاً على كلّ حال)(٣) ... أمّا (إسرائيل ولفنسون) فيتغاضى عن حادثة نعيم بن مسعود في معركة الخندق، كسببٍ في انعدام الثقة بين المشركين واليهود.
رابعاً: تصوير مواقف الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من اليهود وقبائل العرب الجاهليّة، على أنّها ظلمٌ وتعسّف. ومن أمثلة ذلك ما أشار إليه المستشرق (اسرائيل ولفنسون) بصدد مهاجمة يهود بني النضير، حيث إنّه لا يقرّ بما قاله مؤرّخو الإسلام، من أنّ سبب إعلان الحرب على يهود بني النضير هو محاولتهم اغتيال الرسول محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، فيقول: (... لكنّ المستشرقين ينكرون صحّة هذه الرواية ويستدلّون على كذِبها بعدم وجود ذكر لها في سورة الحشر التي نزلت بعد إجلاء بني النضير. والذي يظهر
____________________
(١) القيم، ايتين - (الشرق كما يراه الغرب) - المقدّمة ص٤٣ - ٤٤.
(٢) بروكلمان، كارل ( pockelmann ١٨٦٨ - ١٩٥٦م): مستشرق ألماني يُعتبر أحد أبرز المستشرقين في العصر الحديث. أشهر آثاره: (تاريخ الأدب العربي) في خمسة مجلّدات (١٨٩٨ - ١٩٤٢م)، و(تاريخ الشعوب والدول الإسلاميّة)(عام ١٩٣٩م)، وقد نقلهُ إلى العربيّة نبيّه أمين فارس ومنير البعلبكّي / عن البعلبكّي، منير - موسوعة المورد - المجلّد الثاني ص١٢٠.
(٣) بروكلمان، كارل - (تاريخ الشعوب الإسلامية) ص٥٣ - ٥٤.
لكلّ ذي عينين أنّ بني النضير لم يكونوا ينوون الغدر بالنبيّ واغتياله على مثل هذه الصورة؛ لأنّهم كانوا يخشون عاقبة فعلهم من أنصاره، ولو أنّهم كانوا ينوون اغتياله غدراً لما كانت هناك ضرورة لإلقاء الصخرة عليه من فوق الحائط، كان في استطاعتهم أنْ يفاجئوه وهو يُحادثهم إذ لم يكن معه غير قليلٍ من أصحابه)(١) .
أمّا المستشرق(فلهاوزن) فيقول:( لم يبقَ الإسلام على تسامحه بعد بدر، بل شرَع في الأخذ بسياسة الإرهاب في داخل المدينة، وكانت إثارة مشكلة المنافقين علامة على ذلك التحوّل... أمّا اليهود فقد حاول أنْ يُظهرهم بمظهر المعتدين الناكثين للعهد، وفي غضون سنوات قليلة أخرج كلّ الجماعات اليهوديّة أو قضى عليها في الواحات المحيطة بالمدينة، حيث كانوا يكوّنون جماعات متماسكة كالقبائل العربيّة، وقد التمس لذلك أسباباً واهية...) (٢) .
ويتعاطف المستشرق(مرجليوث) مع اليهود، ويرى أنّ اقتحام خيبر محضَ ظلمٍ نزل باليهود لا مبرّر له على الإطلاق(٣) .. ويُؤاخذ المستشرق(نولدكه) القبائل العربيّة، على عدم تحالفهم الدقيق في مواجهة الرسول محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، ويتمنّى (لو أنّ القبائل العربيّة استطاعت أنْ تعقد بينها محالفات عربيّة دقيقة ضدّ محمّد؛ للدفاع عن طقوسهم وشعائرهم الدينيّة، والذود عن استقلالهم، إذن لأصبح جهادَ محمّد جندهَم غير مجدٍ، إلاّ أنّ عجم العربي عن أنْ يجمع شتات القبائل المتفرّقة قد سمح له أنْ يخضعهم لدينه، القبيلة تلو الأُخرى، وأنْ ينتصر عليهم بكلّ وسيلة، فتارةً بالقوّة وتارةً بالمحالفات الوديّة والوسائل السلميّة)(٤) .
____________________
(١) ولفنسون، إسرائيل - (تاريخ اليهود في بلاد العرب) - ص١٣٠ - ١٣٧.
(٢) فلهاوزن، يوليوس - (الدولة العربيّة وسقوطها) - ص١٥ - ١٦.
(٣) الدكتور خليل، عماد الدين - (المستشرقون والسيرة النبويّة) مجلّة منار الإسلام - العدد ٧.
(٤) نولدكه، ثيودور - (تاريخ العالم للمؤرّخين) الجزء ٨ - ص١١.
خامساً: تصوير سيرة النبيّ محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) على أنّها نتاج بيئته: يقول المستشرق(جب):
( إنّ محمّداً ككلّ شخصيّة مُبدعة، قد تأثّرت بضرورات الظروف الخارجيّة عنه المحيطة به، من جهة أُخرى قد شقّ طريقاً جديداً بين الأفكار والعقائد السائدة في زمانه، والدائرة في المكان الذي نشأ فيه... وقليل ما هو معروف - على سبيل التأكيد - عن حياته وظروفه المبكّرة... ولكن الشيء الذي يصحّ أنْ يُبحث ماضيه الاجتماعي....
لقد كان أحد سكان (مدينة) غير رئيسيّة، وليس هناك ما يصحّ أنْ يصوّره بأكثر من أنّه (بدوي)، شارك في الفكرة والنظرة في الحياة التي كانت للبدو الرُحّل من الناس، و(مكّة) في ذات الوقت لم تكن خلاءً بعيداً عن صخب العالم، وعن حركته في التعامل، بل كانت مدينة ذات ثروة اقتصاديّة، ولها حركة دائبة كمركز للتوزيع التجاري بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسّط.
و(سكّانها) مع احتفاظهم بطابع البساطة العربيّة الأوليّة في سلوكهم ومنشآتهم، اكتسبوا معارفَ واسعةً بالإنسان والمدن، عن طريق تبادلهم الاقتصادي والسياسي مع العرب الرحل، ومع الرسميّين من رجال الإمبراطوريّة الرومانيّة، وهذه التجارب قد كوّنت في زعماء مكّة ملَكات عقليّة، وضروباً من الفطنة وضبط النفس لم تكن موجودةً عند كثير من العرب.
ثمّ إنّ (السيادة الروحيّة) التي اكتسبها المكّيون من قديم الزمان على العرب الرحّل، زادت قوّةً ونموّاً بفضل الإشراف على عدد من (المقدّسات الدينيّة) التي وجِدت داخل مكّة وبالقرب منها، وانطباع هذا الماضي الممتاز لـ (مكّة)، يمكن أنْ نقف على أثره واضحاً في كلّ ادوار حياة محمّد...
وبتعبيرٍ إنساني: إنّ محمّداً نجح لأنّه كان واحداً من المكّيّين!... ولكن بجانب هذا الازدهار في(مكة)، كانت هناك ناحية أُخرى مظلمة خلّفتها تلك الشرور المعروفة لجماعة اقتصاديّة ثريّة، فيها فجوات واسعة من الغنى والفقر! هذه الناحية، هي ناحية الإجرام الإنساني الذي تمثّل في الأرقّاء
والخدَم وفي الحواجز الاجتماعيّة... وواضح من دعوة محمّد الصارخة إلى مكافحة الظلم الاجتماعي، أنّ هذه الناحية كانت سبباً من الأسباب العميقة لثورته الداخليّة (النفسيّة)) !(١)
ويستطرد (جب) في محاولته لإثبات أنّ الاتّجاه الديني للرسول محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وسعْيه لإنشاء حكومة دينيّة وجماعة دينيّة، إنّما كان بتأثير الطابع القدسي الديني لمكّة وزعامتها الدينيّة لباقبي المدن العربيّة الأُخرى، وارتباط وضعها الاقتصادي بهذه الزعامة الدينيّة، الذي أدّى إلى وقوع الصراع بينهم وبين الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من أجل ذلك، فيقول (جب): (ولكن نواة هذه الثورة النفسيّة لم تظهر في صورة (إصلاح اجتماعي)، بل بدلاً من ذلك دفعته إلى (اتجاه ديني) أعلنه في اعتقادٍ ثابت لا يتأرجح: بأنّه رسولٌ من الله، لينذر أتباعه بإنذار الرسُل الساميّين القديم: توبوا، فجزاء الله حق!!. وكل ما وُجِد بعد ذلك كان نتيجةً منتظرة للتصادم بين هذا الاعتقاد (بأنّه رسول) وبين الكفر به، ومعارضته من فريقٍ بعد فريق....
وهناك حقيقة واحدة مؤكّدة (في تاريخه) وهي: أنّ الدافع له كان (دينيّاً) على الإطلاق، فمن بدء حياته كداعٍ كانت نظرته إلى الأشخاص والأحداث وحكمه عليها نظرة تأثر فيها، بما عنده من صورة عن الحكومة الدينيّة وأغراضها في عالم الإنسان!!.. ومحمّد في البداية، لم يكن نفسه على علمٍ بأنّه صاحب دعوةٍ إلى دين جديد! بل كانت معارضة المكّيّين له، وخصومتهم له من مرحلةٍ إلى أُخرى، هي التي قادته أخيراً وهو بالمدينة - بعد أنّ هاجر إليها - إلى إعلان الإسلام كجماعة دينيّة جديدة، بإيمانها الخاص، وبمنشآتها الخاصّة.
ويبدو أنّ معارضة المكّيّين له لم تكن محافظتهم وتمسّكهم بالقديم، أو
____________________
(١) جب، (المذهب المحمّدي) ص٤٧.
بسبب عدم رغبتهم في الإيمان، بل ترجع أكثر ما ترجع إلى أسباب سياسيّة واقتصاديّة، لقد تملّكهم الخوف من آثار دعوته، التي تؤثّر على ازدهارهم الاقتصادي وبالأخص تلك الآثار التي يجوز أنْ تلحق ضرراً بالقيمة الاقتصاديّة لمقدّساتهم... وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ المكيّين قد تصوّروا - أسرع ممّا تصوّر محمّدٌ نفسه - أنّ قبولهم لتعاليمه ربّما يُمهّد لنوعٍ معقّد من السلطة السياسيّة داخل جماعتهم، التي كانت تحكمها فئة قليلة حتّى ذلك الوقت)(١) .
سادساًَ: يقول الدكتور(رشدي فكار): إنّ محاولة المستشرقين تحقيق مخطّطاتهم بالنفاذ من باب السيرة النبويّة، والتعامل معها كتراث بشري دنيوي، لا كمعتبِر لوحي السماء. وقد قام المستشرق (جولد صيهر) بدور رئيس في التشكيك بصدق السنة النبويّة، حيث ادّعى هو وغيره أنّها جُمِعت بعد وفاة النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بوقتٍ طويل، وهذا يفقدها الكثير من مصداقيّتها، بل راح إلى أبعد من ذلك، فادّعى أنّ الحديث النبوي هو نتيجة لتطوّر المسلمين.
أمّا المستشرق(الفريد غيوم) في كتابه (الحديث في الإسلام) والمستشرق(تريثون) في كتابه (الإسلام عقيدة وعمل)، فقد حاول كل منهما الطعن في طرق جمع السنة المطهرة، زاعمين أنّ السنة النبويّة الصحيحة لم يُكتب لها البقاء؛ لأنّها لم تدوّن، بل كانت تُتناقل شفاهةً بين الأفراد لمدّة قرنين من الزمان(٢) .
ويشير المستشرق(درمنغهام) إلى هذه الادّعاءات، ويذكر لنا نمطاً آخر منها فيقول: (من المؤسف حقّاً أنْ غالى بعض هؤلاء المتخصّصين - من أمثال (موبر) و(مرجليوث) و(نولدكه) و(سبرنجر) و(دوزي) و(كيتاني) و(مارسين) و(غريم) و(جولد صيهر) و(غود فروا) وغيرهم - في النقد أحيانا، فلم تزل كتبهم عاملَ هدمٍ على الخصوص، ومن المُحزن
____________________
(١) جب، (المذهب المحمّدي) - ص٢٧ - ٢٩.
(٢) الجندي، أنور - (أبرز أهداف المستشرقين) - مجلّة منار الإسلام - العدد ٨ السنة ١٤.
ألاّ تزال النتائج التي انتهى إليها المستشرقون سلبيّةً ناقصة...
ومن دواعي الأسف أنْ كان الأب(لامانس)، الذي هو من أشهر المستشرقين المعاصرين من أشدّهم تعصّباً، وأنّه شوّه كتبه الرائعة الدقيقة وأفسدها بكرهه للإسلام ونبيّ الإسلام، فعند هذا العالِم اليسوعي أنّ الحديث إذا وافق القرآن كان منقولاً عن القرآن، فلا أدري كيف يُمكن تأليف التاريخ، إذا اقتضى تطابق الدليلين تهادمهما بحكم الضرورة، بدلاً من أنْ يؤيّد أحدهما الأخر؟)(١) .
والأكثر غرابة هو موقف بعض المستشرقين من القرآن كمصدر أساسي من مصادر السيرة النبويّة، فهم ينفون الكثير من وقائع السيرة إذا لم تكن واردة في القرآن الكريم، وهم بعبارةٍ أُخرى، يريدون أنْ يُوهموا بهذه الحجّة أنّ عمليّة انتقائهم المغرضة لبعض وقائع السيرة، وترك البعض الأخر - بهدف هدم هذه السيرة ونفيها - لم يكن جزافاً، بل كان على أساس الاتّكاء على المصدر الفيصل لدى المسلمين، في بيان حقائق دينهم ونبيّهم.
ومن الأمثلة على ذلك ما يدّعيه المستشرق(شبنغلر) (٢) من أنّ اسم النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ورد في أربع سوِر من القرآن هي آل عمران والأحزاب ومحمّد والفتح، وكلّها سوِر مدنيّة، ومِن ثمّ فإنّ لفظة(محمّد) لم تكن اسم علَم للرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قبل الهجرة، وإنّما اتّخذه بتأثير قراءته للإنجيل واتّصاله بالنصارى(٣) ، ومن الأمثلة أيضاً ما أشار إليه المستشرق(إسرائيل
____________________
(١) درمنغهام، إميل - (حياة محمّد) - المقدّمة ص٨، ١٠ - ١١.
(٢) شبنغلر، (أوزوولد Spengler Oswald ١٨٨٠ - ١٩٣٦م): فيلسوف ألماني قال بأنّ الحضارات تولد وتنضج ثمّ تموت كالكائنات الحيّة سَواء بسواء، وأنّ الحضارة الغربيّة المعاصرة هي في طريقها إلى الموت، وبأنّ حضارة أُخرى جديدة من آسيا سوف تحلّ محلّها، أهمّ آثاره: (انحطاط الغرب) وهو يقع في مجلّدين.
عن البعلبكّي، منير - موسوعة المورد م٩ ص١٠١.
(٣) علي، جواد. (تاريخ العرب في الإسلام) الجزء الأول ص٧٨ وهوامشها، ويمكننا أنْ ننقض على (شبنغلر) هذا فنسأله: إذا كان النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قد التقط اسم محمّد من خلال قراءته لنبوءات الإنجيل، = فأين إذن (محمّد) الحقيقي الذي بُشر به في كتب النصارى؟
ولفنسون) - الذي مرّ ذكره - بصدد مهاجمة يهود بني النضير، من أنّ مؤرّخي المسلمين يذكرون سبباً آخر لإعلان الحرب على هذه الطائفة اليهوديّة، ذلك هو محاولتهم اغتيال الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم).
ويدّعي(ولفنسون) أنّ المستشرقين يقولون بغير ذلك فيقول: (لكنّ المستشرقين ينكرون صحّة هذه الرواية ويستدلّون على كذبها بعدم وجودِ ذكرٍ لها في سورة الحشر، التي نزلت بعد إجلاء بني النضير)(١) .
ويُعتبر ما ذكره(مونتغمري وات) - بصدد تثبيت الشبهات وتكريس الشكوك حول معطيات السيرة النبويّة، ومصداقيّتها القدسيّة، على أساس الدليل والحجّة القاطعة - قناعاً يقنع به ذلك المنهج الاعتباطي المُغرض؛ لأنّه هو نفسه لم يلتزم بما قاله، وكشف من خلال كتاباته زيف ادّعائه وحقيقة منهجه الكيفي، ممّا يجعلنا نتحفّظ من قوله: (إذا أردنا أنْ نصحّح الأغلاط المكتسبة من الماضي بصدد (محمّد)، فيجب علينا في كلّ حالة من الحالات لا يقوم الدليل القاطع على ضدّها أنْ نتمسّك بصلابة بصدقه، ويجب أنْ لا ننسى أيضاً أنّ الدليل القاطع يتطلّب لقبوله أكثر من كونه ممكناً، وأنّه في مثل هذا الموضوع يصعب الحصول عليه)(٢) .
سابعاً: الانطلاق من المنطق الوضعي العلماني، وطريقة التفكير الأوربيّة في تناول السيرة الشريفة للنبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأهل بيته (عليهم السلام): حاول المستشرقون أنْ يخترقوا السيرة النبويّة، ويُخضعوا حياة نبيّ الإسلام (محمّد) (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأهل بيته (عليهم السلام) لعلوم الغربيّين في التربية والسيكولوجيا(٣) .
إنّ المنطق الوضعي العلماني والرؤية الأوربيّة في منهج البحث التاريخي أدّى
____________________
(١) ولفنسون، إسرائيل - (تاريخ اليهود في بلاد العرب) - ص١٣٥ - ١٣٧.
(٢) وات، مونتغمري - (محمّد في مكّة) - ص٩٤.
(٣) الجندي، أنور - (أبرز أهداف المستشرقين) - مجلّة منار الإسلام العدد ٨ - السنة ١٤.
إلى أنْ تقع مجموعة من المستشرقين في تزوير وتحريف الحقائق التاريخيّة، منها قولهم: (إنّ الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لم يكن يخطو خطوةً واحدة، وهو يعلم مسبقاً ما الذي يليها...)، أي إنّه كان يتحرّك وفق ما تمليه عليه الظروف الراهنة من متطلّبات ولوازم، دونما أيّ تخطيط شمولي وأُفقٍ عالمي، كما هو وارد في القرآن الكريم ومتواتر فيما نُقل من السيرة النبويّة.
ومن أبرز من تبنّى هذه المقولة هو المستشرق(فلهاوزن) ومجموعته الاستشراقيّة، إذ قالوا بإقليميّة دعوة الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) للإسلام في عصرها المكّي، وإنّه لم ينتقل إلى المرحلة العالميّة - في العصر المدني - إلاّ بعد أنْ أتاحت له الظروف ذلك، ولم يكن ليفكّر بذلك من قبل.
وقد أشار المستشرق(سير توماس أرنولد) إلى هذه الرؤية الخاطئة لدى زملائهِ بقوله: (من الغريب أنْ ينكر بعض المؤرّخين أنّ الإسلام قد قُصد به مؤسّسه في بادئ الأمر، أنْ يكون ديناً عالميّاً برغم هذه الآيات البيّنات)(١) .
وقد سبقَت الإشارة إلى أنّ المستشرق الفرنسي(دينيه)، الذي أعلن إسلامه قال في هذا الصدد أيضاً: (إنّه من المتعذّر إنْ لم يكن من المستحيل، أنْ يتجرّد المُستشرقون عن عواطفهم وبيئتهم نزعاتهم المختلفة، وإنّهم لذلك قد بلغ تحريفهم لسيرة النبيّ والصحابة مَبلغاً يُخشى على صورتها الحقيقيّة من شدّة التحريف فيها، ورغم ما يزعمون من أتباعهم لأساليب النقد البريئة ولقوانين البحث العلمي الجاد، فإنّا نلمس من خلال كتاباتهم محمّداً (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يتحدّث بلهجةٍ ألمانيّة إذا كان المؤلّف ألمانيّاً، وبلهجةٍ إيطاليّة إذا كان الكاتب إيطاليّاً.
وهكذا تتغيّر صورة محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بتغيّر جنسيّة الكاتب، وإذا بحثنا في هذهِ السيرة عن الصورة الصحيحة فأنا لا نكاد نجد لها من أثر.
إنّ المستشرقين يقدّمون لنا صوراً خياليّة
____________________
(١) أرنولد، سير توماس - (الدعوة إلى الإسلام) - ص٤٨.
هي أبعد ما تكون عن الحقيقة، إنّها أبعد عن الحقيقة من أشخاص القصص التأريخيّة التي يؤلّفها أمثال (وولتر سكوت) و(الكسندر دوماس).
وذلك أنّ هؤلاء يصوّرون أشخاصا من أبناء قومهم، فليس عليهم إلاّ أنْ يحسبوا حساب اختلاف الأزمنة، أمّا المُستشرقون فلم يمكنهم أنْ يلبسوا الصورة الحقيقيّة لأشخاص السيرة فصوّروهم حسب منطقهم الغربي وخيالهم العصري...).
ولتقريب الفكرة يضرب(دينيه) مثلاً عكسيّاً: (ما رأي الأوربيّين في عالم مِن أقصى الصين يتناول المتناقضات، التي تكثر عن مؤرّخي الفرنسيّين ويمحصّها بمنطقه الشرقي البعيد، ثمّ يهدم قصّة(الكاردينال ريشيليو) (١) كما نعرفها ليعيد إلينا ريشيليو آخر له عقليّة كاهن من كهنة بكّين وسماته وطباعه؟
إنّ مستشرقي العصر الحاضر قد انتهوا إلى مثل هذه النتيجة، فيما يتعلّق برسمهم الحديث لسيرة الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، ويُخيّل الينا أنّنا نسمع محمّداً (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يتحدّث في مؤلّفاتهم إمّا باللهجة الألمانيّة أو الانجليزيّة أو الفرنسيّة، ولا نتمثّلهُ قط بهذه العقليّة والطباع التي ألصقت به، يحدّثُ عُرباً باللغة العربيّة)، ويختم هذا المستشرق المسلم كلامه بالقول: (إنّ صورة نبيّنا الجليلة التي خلّفها المنقولٍ الإسلامي، تبدو أجمل وأسمى إذا قيست بهذه الصورة المصطنعة الضئيلة، التي صيغت في ظلال المكاتب بجهدٍ جهيد)(٢) ، وأخيرا فإنّ هذا النمط من أنماط النماذج المختارة في العقليّات
____________________
(١) (ريشيليو)، آرمان جان دوبليسي (١٥٨٥ - ١٦٤٢م) كاردينال وسياسي فرنسي، كبير وزراء لويس الثالث عشر والحاكم الفعلي لفرنسا (١٦٢٨ - ١٦٤٢م) قضى على نفوذ نبلاء الإقطاع ونفوذ البروتستانت السياسي. سعى إلى إذلال آل هابسبورغ في حرب الأعوام الثلاثين. أجرى إصلاحات ماليّة وعسكريّة وتشريعيّة، وشجّع التجارة، ورعى الفنون، وأنشأ الأكاديميّة الفرنسيّة. عن البعلبكّي، منير - (المورد) - الجزء الثامن - ص١٥٠.
(٢) دينيه، إيتين - (محمّد رسول الله) - ترجمة عبد الحليم محمود - المقدّمة ص٢٧ - ٢٨، ٤٣ - ٤٤.
الاستشراقيّة والمصبّات الموضوعيّة، التي وقع الجهد الاستشراقي عليها، يكشف لنا بوضوح مدى التعصّب والمنهجيّة المغرضة، والدوافع التبشيريّة والاستعماريّة في وقائع الحركة الاستشراقيّة وأعمال المستشرقين، فكانت النتائج التي تمخضّت والمعطيات التي أُفرِزت ذات ثلاثة أبعاد أساسيّة:
الأوّل: كان بمثابة مسح ميداني للشرق الإسلامي فكريّاً وحضاريّاً.
الثاني: التشويه الموضوعي للفكر الإسلامي والحضارة القائمة عليه، بهدف منع تأثّر المجتمع الأوربّي به، إضافةً إلى تكوين ارتكاز ذهني عن تخلّف المسلمين وجهلهم المركّب ليكون مبرّراً لاستعمارهم.
الثالث: النيل من العقائد الإسلاميّة (في القرآن وفي الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم)... إلخ)، وتشويه حقائقها بهدف نفي قدسيّتها من نفوس المسلمين، وبذلك يمكن فكّ الارتباط بينهم وبين معتقداتهم، ليتم الجانب السلبي من عمليّة التغيير للمجتمعات الإسلاميّة.
وبهذه الأبعاد أو قل المقدّمات الثلاث تتهيّأ الأرضية المناسبة لقيام أوربّا بالغزو التبشيري والاستعماري للشرق الإسلامي فكريّاً وسياسيّاً وعسكريّاً، فيبرز الجانب الايجابي من عمليّة التغيير للمجتمعات الإسلامية إلى الواقع.
الفصل الخامس
نماذج من كبار المستشرقين في منهج
تناولهم للشّرق الإسلامي
* ارندجان فنسنك Arandjan Wensink
* صموئيل زويمر Samual Zwemer
* لويس ماسنيون Louis Massignon
طيلة قرون وحتّى فترة متأخّرة من القرن العشرين، لم تتعرّف الشعوب الغربيّة على الشرق الإسلامي، من خلال مصادره الخاصّة وتراثه المباشر، وإنّما عرفوه من خلال رجال متخصّصين، وعلى رأسهم المستشرقون الذين جالوا بلدان الشرق الإسلامي، وسجّلوا مشاهداتهم الحسيّة من الواقع، ونقلوا إلى جامعاتهم ومعاهدهم الآلاف من الكتب والمصادر والوثائق، وأخضعوها للدرس والتحليل.
وعلى أساس من خلفيّاتهم الغربيّة ومنطقهم العلماني وشعورهم الاستعدائي لكلّ ما ينتمي للإسلام فكراً ومجتمعاً، واستهدافهم المتناغم مع التطلّعات الاستعماريّة لدول الغرب، صوّروا الإسلام ومجتمعه للغربيّين، بل طرحوه لأُمم العالم وشعوبه بثوبٍ جديد نسجته عقولُهم على ضوء نظريّتهم وخلفيّاتهم تلك، فخرج مشوّهاً في حقيقته، مزيّناً بأثوابِ التحديث وبريق التقدّم الزائف، حتّى أصبحت كتبهم ومؤلّفاتهم عن الشرق الإسلامي هي المصادر الأساسيّة، ومراجع التعريف والدراسة الوحيدة تقريباً للشرق الإسلامي في جميع معاهد وجامعات الغرب، بل وأغلب الجامعات التي أُنشئت على المنهج الغربي في أنحاء العالم.
وفي سبيل تسليط الضوء على هذه الحقيقة، رأينا أنْ ندرس منهج تفكير وطريقة تناول نماذج من رجال الغرب، تُعتبر من أكبر مَن تصدّى لدراسة الشرق الإسلامي وتعريفه، والعمل على أرضه وفي وسط مجتمعاته، ولا يمكننا أنْ نخرج عن دائرة المستشرقين في هذه النماذج؛ لأنّهم هُم وحدهم الذين تتوفّر فيهم خصائص الشموليّة والتخصّص في مثل هذه الدراسات، خصوصاً وأنّ كبارهم هم أصحاب
مدارس متميّزة ورائدة في مجال دراسة الشرق الإسلامي إيديولوجيّاً واجتماعيّاً.
إنّ انتقاءنا لنماذج من كبار رجال الاستشراق، سيكون منسجماً مع هدفنا في تشخيص وتقويم منهج دراسة الغربيّين للشرق الإسلامي وتعريفه، كما أنّ الأساس الذي اعتمدناه في هذا الانتقاء هو الدور الخطير فكريّاً وميدانيّاً لهؤلاء الرجال، والذي سيكشف لنا عن الأثر السلبي الكبير الذي تركوه على الذهنيّة الغربيّة في فهم الإسلام ومجتمعاته من جهة، وعن التخريب الفكري والاجتماعي الذي أحدثوه في المجتمعات الإسلاميّة، عن طريق صياغة إيديولوجيّات وبرامج تغيير لحرف توجّهات هذه المجتمعات عن مسارها الإسلامي، ومحق هويّتها الدينيّة من جهة أُخرى.
وبذلك استغنى الاستعمار الغربي عن الأُسلوب العسكري المباشر في السيطرة على الشرق الإسلامي، واكتفى بالاستعمار الفكري والمنهجي، المتمثّل بجملة من المبادئ والأُطروحات الحديثة التي أُلبست ثوب القوميّة أو الوطنيّة تارة، وثوب التمدّن والتحديث تارةً أُخرى، وثوب الدفاع عن حقّ الشعوب وحريّتها الفكريّة تارةً ثالثة.
وفيما يلي ثلاثة نماذج رائدة في هذا المجال نتناولها تِباعاً:
أرندجان فنسنك Arendjan Wensink
(١٢٩٩ - ١٣٥٨هـ، ١٨٨٢ - ١٩٣٩م)
هو مستشرق هولندي كان أُستاذ اللغة العربيّة في جامعة ليدن من سنة ١٩٢٧م إلى مماته، وقام برحلات إلى مصر وسورية وغيرها من بلاد العرب.
اهتمّ بالحديث النبويّ، وتولّى الإشراف على تحرير معظم موضوعات (دائرة المعارف الإسلاميّة) سنة ١٩٢٥م بلغاتها الثلاث، فأتمّ منها أربعة مجلّدات وخمس ملازم، وكتب مقالات كثيرة في مجالات مختلفة، وله كتب بالإنجليزيّة عن الإسلام والمسلمين(١) .
رُشّحفنسنك لعضويّة مجمع اللغة العربيّة في مصر، ولشدّة تعصّبه ضدّ الإسلام تعرّض لهجوم من قِبل الدكتورحسين الهواري مؤلّف كتاب(المستشرقون والإسلام) ، الذي صدر سنة ١٩٣٦م ممّا أحدث أزمةً معه كانت نتيجتها أنْ أُخرجفنسنك من عضويّة المجمع، وكان السبب في هذا الهجوم قيامه بنشر رأيه في القرآن والرسول، مدّعياً أنّ الرسول ألّف القرآن من خلاصة الكتب الدينيّة والفلسفيّة التي سبقته(٢) .
ولهذا عُرف بأنّه عدوٌّ لدود للإسلام ونبيّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، ومتعصّب بكتاباته كما في
____________________
(١) الزركلي، خير الدين - الأعلام (قاموس تراجم) ١: ٢٨٩.
(٢) د. الهواري، حسين - المستشرقون والإسلام: ٧١٠ وما بعدها.
كتابه(عقيدة الإسلام) الذي صدر في سنة ١٩٣٢م(١) .
ولمّا كانت مدينة(ليدن) وجامعتها في هولندا قد اشتهرت بغزارة إنتاجها الاستشراقي، فقد ترأّسفنسنك ، الذي كان يدرّس فيها، مجموعة من زملائه للقيام بعملَين كبيرين:
أوّلهما: دائرة المعارف الإسلاميّة، وصدر الجزء الأوّل منها عام ١٩١٣م، التي ضمّنها أخطر آرائه، منها ما ورد في كلمة (إبراهيم) وفي كلمة (كعبة).
فقد أشار تحت لفظ (إبراهيم) إلى أنّ الآيات الكميّة ليس فيها ذكر لنسب إسماعيل لإبراهيم، ويقول: إنّه لا يعرف شيئاً عن شعور محمّد نحو الكعبة في شبابه، وإنّ ما لديه مِن تاريخ حياته لا يصحّ أنْ يُؤخذ أساساً تاريخيّاً. وينسب فنسنك إلى النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أنّه لم يشذّ عن الجماعة في العبادة المكيّة، أي بعبارةٍ أكثر وضوحاً أنّه كان وثنيّاً قبل البعثة، ويفتري فنسنك حين يصرّح أنّ كلمة إبراهيم اخترعت اختراعاً، ويزعم أنّ محمداً أراد بهذا الاختراع أنْ يتّصل بإبراهيم(٢) .
ويطرح رأيه هذا ليؤكّد نفس المقولة التي ردّدها أسلافه اليهود والنصارى، عندما بُعث النبيّ محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بالإسلام، والتي ردّدها القرآن الكريم بقوله تعالى: ( مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلا نَصْرَانِيّاً وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً.... ) (٣) .
ويستمرّ فنسنك في افتراءاته فيُشارك كلّ من المستشرقين(سبرنجر) و(سنوك) ، في ترجمة النبيّ إبراهيم (عليه السلام) ضمن دائرة المعارف الإسلاميّة قائلاً: إنّ القرآن لم يحفل بإبراهيم، ولم يذكر أُبوّته لإسماعيل، ولا أُبوّته للإسلام، إلاّ في السور المدنيّة، وسرّ هذا الاختلاف أنّ محمّداً اعتمد على اليهود في مكّة، فلمّا اتّخذوا حياله
____________________
(١) د. البهي، محمّد - الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي: ٥٥٥.
(٢) الجندي، أنور - الموسوعات الغربيّة من أخطر أعمال التغريب والغزو الثقافي - مجلّة منار الإسلام، العدد ٦، السنة ١١.
(٣) آل عمران: ٦٧.
العداء لم يجد بُدّاً من أنْ يلتمس غيرهم ناصراً، هناك هداه ذكاءٌ شديد إلى شأنٍ جديد لأبي العرب إبراهيم، وبذلك استطاع أنْ يتخلّص من يهوديّة عصره ليصل حبله بيهوديّة إبراهيم، تلك اليهوديّة التي كانت ممّهدة للإسلام(١) .
ثانيهما: في مجال فهرست السنّة أصدر كتابين: أحدهما: معجم بالإنجليزية، للألفاظ الواردة في أربعة عشر كتاباً من كتب السنن والسيرة. نقله إلى العربيّة الأُستاذ محمّد فؤاد عبد الباقي، وسمّاه(مفتاح كنوز السنّة) .
والآخر: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويّ الذي نشره بالعربيّة وتوفّي قبل إتمامه(٢) .
وقد حقّق فنسنك بهذا المشروع الضخم هدفين أساسيّين، كان يسعى إليهما أغلب المستشرقين في أعمالهم الاستشراقيّة في هذا الباب العلمي. الهدف الأوّل: هو تيسير العمل أمام المستشرقين، لتناول السيرة النبويّة بشكلٍ تفصيلي دقيق يمكّنهم من استقصاء ما يُمكن أنْ يكون - بعد العلاج - مورداً للنقض والتشكيك والنيل من الإسلام ونبيّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم).
والهدف الثاني: تحويل توجّه الكتّاب والباحثين عن السنّة النبويّة إلى المراجع الاستشراقيّة، خصوصاًَ إذا لوحظ امتيازها الفنّي والموسوعي، ممّا يجعلها في الصدارة والمجال الأوّل بين مراجع المسلمين، فيعتمدون عليها ويكتفون بها رغم ما فيها من خلطٍ وتحريفٍ وافتراء، وينسون مع تقدّم الزمان مراجعهم الأصليّة.
وفي هذا المجال يقول الشيخ محمّد حسام الدين: وكان أخطر عملهم في مادّة (حديث) ومادّة (سنّة)، لنجد فيها ما يجرح الإسلام وما يُفسد الحقيقة، وأنّهم يقدّمون الشبهات في أساليب يعجز عنها الشيطان، وذلك ما رمى إليه (فنسنك)، وهو الطعن على وجهٍ أشدّ في المصدر الثاني بعد كتاب الله وهو السنّة النبويّة، بل بوصفها البيان لكتاب الله تعالى، فإذا جرى الاعتماد على
____________________
(١) دائرة المعارف الإسلاميّة - مادّة إبراهيم.
(٢) الزركلي، خير الدين - الأعلام (قاموس تراجم) ١: ٢٨٩.
مراجعهم كان هذا شديد الخطر على الإسلام والأجيال القادمة(١) .
وقد أدخل فنسنك بكتابيه(كنوز السنّة) و(المعجم المفهرس لألفاظ الحديث) أخبار وتقارير شاذّة وواهية مردودة نثرها في الكتابين، ودسّها في سياق الصحيح لتسوغ معه وتشتبه به، وليستقرّ في ذهن القارئ أنّها من الثوابت الواردة عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وبعضه يصل إلى درجة الشناعة وتبرأ منه السنّة الشريفة.
وإنّ اعتماد المنهج العقلي والعلمي يقتضي التنويه - ولو إجمالاً - إلى أنّ الأخبار والروايات المنسوبة إلى السنّة الشريفة فيها الصحيح الموثّق، وفيها الضعيف والمرسل والمتروك، ويُطلب من القارئ - على الأقلّ - مراجعة المصادر الخاصّة ببيان قواعدها وطُرق التثبّت منها.
____________________
(١) الجندي، أنور - أبرز أهداف المستشرقين، مجلّة منار الإسلام، العدد: ٨، السنة: ١٤.
صموئيل زويمر Samual Zwemer (١٨٦٧ - ١٩٥٢م)
من أبرز المستشرقين الأميركيّين الذين خاضوا عملهم ميدانيّاً في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً جنوب العراق ودول الخليج العربيّة، وهو المحرّر للمجلّة الإنجليزيّة الاستشراقيّة الشهيرة(عالم الإسلام) ، وقد اشتهر بدوره التبشيري وعِدائه الشديد للإسلام.
له مؤلّفات عديدة عن الإسلام في العالم، وعن العلاقات بين المسيحيّة والإسلام، منها: كتاب(يسوع في إحياء الغزالي) ، وكتاب(الإسلام تحدٍ لعقيدة) صدر سنة ١٩٠٨م، وكتاب(الإسلام) وهو مجموعة مقالات قدّمت للمؤتمر التبشيري الثاني سنة ١٩١١م بمدينة(لكناو) في الهند.
ويعتبر(زويمر) من أكثر المستشرقين توجّهاً نحو التنصير، وتقديراً لجهوده التبشيرية أنشأ الأميركيّون وقفاً باسمه على دراسة اللاهوت وإعداد المبشّرين(١) .
وكانت أُولى أعماله الميدانيّة اختياره عضواً في الإرساليّة الأميركيّة العربيّة عام ١٨٨٩م(٢) ، وهي إرساليّة أميركيّة بروتستانتيّة ذات أهداف تبشيريّة في
____________________
(١) د. البهي، محمّد - الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي: ٥٥٣ - ٥٥٤.
(٢) قام الدكتور(لا نسننج) وهو أُستاذ اللغة العربيّة في معهد اللاهوت فينيوبرونسوك في ولاية نيوجرسي الأميركيّة بتدريب المبشّرين التابعين لكنيسة الإصلاح في الولايات المتّحدة الأميركيّة، وثلاثة من مساعديه وهُم: جيمس كانيتن، وصموئيل زويمر، وفيليب فيلبس بتشكيل هذه الإرساليّة، وكان اسمها الأصلي (العَجَلَة The Weel ) وقد أطلق الدكتور لانسننج ومساعدوه هذا الاسم عليها، ولكنّه اضطرّ لتغييره إلى الإرساليّة العربيّة عام ١٨٨٩م، تلبيةً لطلبٍ رسميٍّ مقدّم إلى هيئة الإرساليّات الأجنبيّة = التابعة لكنيسة الإصلاح في أميركا؛ للسماح بالقيام بعمل تبشيري في البلاد الناطقة بالعربيّة.
عن د. التميمي - عبد الملك خلف، كتاب (التبشير في منطقة الخليج العربي): ٤٥ - ٤٦.
منطقة الخليج العربيّة وشبه الجزيرة العربيّة (الحجاز)، وقد كانت المهمّة الرئيسيّة للإرساليّة هي التبشير والتعليم الديني، وتقديم الخدمات الطبيّة والصحيّة من خلال الواجهة التبشيريّة، وكانت عمليّاتهم اليوميّة تُدار من قِبل لِجان مُشكّلة لهذا الغرض محليّاً، وذلك وفق خطّة عمل الإرساليّة تحويل أهالي الجزيرة العربيّة إلى الديانة المسيحيّة، حيث تقول(آن هاريسون) : لقد أُرسلنا لتحويل الناس إلى المسيحيّة والدعوة إلى قدرة الله(١) .
وهكذا فإنّ هدف صموئيل زويمر - الذي كان من أبرز رفاقه في الإرساليّة نشاطاً واندفاعاً(الدكتور لانسننج) - دفع جميع بني الإنسانيّة ليصبحوا أتباعاً للسيّد المسيح (عليه السلام)، وكانت خطّة الإرساليّة تجسيداً لهذه الأفكار، وقد عمل (زويمر) وصحبه كلّ ما بوسعهم لإرساء دعائم هذه الإرساليّة.
ولمعرفة طريقة ومنهج تفكير وعمل (زويمر) يُطرح السؤال التالي: لماذا اختاروا اسم (الإرساليّة العربيّة) لهذه المنظمة التبشيريّة؟ وجوابه نجده في متن الخطّة(٢) التي وضعها زويمر ورفاقه وهي:
١ - إنّ الهدف الأساسي لهذه المنظمة كان العمل التبشيري في البلاد العربيّة، وبشكلٍ أساسي شبه الجزيرة العربيّة، التي هي موطن العرب والدين الإسلامي.
٢ - إنّهم أرادوا أنْ تكون هذه الإرساليّة مختلفةً ومميّزة عن غيرها من الإرساليّات المسيحيّة؛ لكي تستطيع أنْ تلفت الانتباه لهذا الميدان الجديد الذي
____________________
(١) HARRISON - Ann – Atol in his hand, N Y. ١٩٥٨ p. ١٢٦.
عن د. التميمي - عبد الملك خلف، كتاب (التبشير في منطقة الخليج العربي).
(٢) د. التميمي، عبد الملك خلف، التبشير في منطقة الخليج العربي، الملحق الأوّل، خطّة الإرساليّة الأميركيّة العربيّة: ٣١٧ - ٣١٨.
كانوا يعتقدون أنّه مهيّأ لاستقبال أمثال هذه الدعوة.
٣ - إنّ اختيار الاسم يهدف إلى التغلّب على الشكوك التي يحملها العرب نحو أنشطة الأجانب، وهذه الشكوك كانت طبيعيّة جدّاً، خصوصاً في ذلك الوقت عندما كان الصراع الأجنبي على أشدّه في منطقة الخليج العربيّة بشكلٍ خاص. وقد وضعت الأُصول العامّة لنشاط الإرساليّة في المرحلة المُقبلة واختيرت الجزيرة العربيّة هدفاً لها.
وعن الأسباب التي دعت لاختيار الجزيرة العربيّة هدفاً للإرساليّة يقول(صموئيل زويمر) : إنّ من بين الدوافع للعمل في (الجزيرة العربيّة)....
أولاً: الأسباب التاريخيّة. إنّ للمسيح حقّاً في استرجاع الجزيرة العربيّة، وقد أكّدت الدلائل التي تجمّعت لدينا في الخمسين سنة الأخيرة، على أنّ المسيحيّة كانت منتشرة في هذه البلاد في بداية عهدها، وهناك دلائل أثريّة واضحة على وجود الكنيسة المسيحيّة هناك، ولهذا فإنّ من واجبنا أنْ نعيد هذه المنطقة إلى أحضان المسيحيّة(١) .
والسبب الثاني هو أنّ النجاح المسيحي في الجزيرة العربيّة سيكون نقطة تحوّلٍ في العمل التبشيري المسيحي، وهذه الفكرة كانت تفترض أنّ نجاحهم سيكون منطلقاً لفتح أبواب المنطقة بأكملها أمام التبشير المسيحي.
إنّ أهمّ ما قامت به الإرساليّة أنّها قدّمت للمبشّرين الأميركيّين مساعدات قيمة، وأهمّ هذه المساعدات ما يتعلّق بتقديم المعلومات عن أحوال المنطقة وخصوصاً الجغرافيّة والاجتماعيّة والدينيّة، بالإضافة إلى هذا، فإنّ الإرساليّة العربيّة حصلت على تعاون المنظّمات المشابهة في العراق كالإرساليّة المتّحدة في العراق، والمجلس المسيحي للشرق الأوسط، وجمعيّة الكنيسة التبشيريّة، وكانت أُولى محطّات العمل
____________________
(١) Zwemer. S. M. and Cantine, J, OP Cit, pp. ١٤١ – ٢.
عن د. التميمي، عبد الملك خلف: كتاب التبشير في منطقة الخليج العربي.
الميداني لهذه الإرساليّة هي البصرة، التي أصبحت فيما بعد مركزاً وقاعدةً لعمليّاتهم في منطقة الخليج العربيّة، وهي من بين المناطق الهامّة التي كانوا يخطّطون لاحتلالها(١) .
وكان الرائد الأوّل للعمل في هذه المحطّة هو المستشرق (صموئيل زويمر)، الذي كان يحظى بحماية القنصليّة الأميركيّة في البصرة من ردود فعل المواطنين وقياداتهم الدينيّة التي كان بواجههما بالإضافة إلى سلطات الدولة العثمانيّة.
ومن البصرة بدأ عمل الإرساليّة بقيادة (زويمر) لتغطية معظم أراضي الخليج، وبعض أجزاء شبه الجزيرة العربيّة، ممهّدين لذلك برحلات استكشافيّة لدراسة الأوضاع الجغرافيّة والسياسيّة بشكلٍ مباشر، ثمّ على ضوئها يتمّ التخطيط للامتداد في المناطق المناسبة، ويبدأ العمل تدريجيّاً حتّى تثبت أقدامهم في تلك المناطق.
وقد استطاعوا أنْ يستقرّوا في البحرين ثمّ في مسقط، وهكذا في الكويت وقطر، ثمّ تلتها المحطّات الفرعيّة كالعمارة والناصريّة في العراق، وميناء مطرح في مسقط.
وقد اشتهر (زويمر) هذا بأنّه كان يلقّب نفسه بـ (ضيف الله) عند تردّده بين البصرة والبحرين والإحساء، وكان عمليّاً جداً، بحيث إنّ أوّل أعماله ضمن الإرساليّة الأميركيّة العربيّة فتحه حانوتاً في السوق لبيع الكتب المختلفة، ثمّ
____________________
(١) إنّ كلمة (احتلال المنطقة) استخدمها المستشرقون المبشّرون في أدبيّاتهم، وهي أقرب إلى اللغة العسكريّة منها إلى التبشير السلمي الذي يدعون لأجله.
The Arabian Mission Correspondence ١٨٩٠ – ١٨٩٨ Archives No. ٧٥٣ – Box VI. Letter From Rev. – J. Contian to the Board dated May ٢٦ – ١٨٩٢ , the theological seminary, new panswick, N. J. U. S. A
عن د - التميمي، عبد الملك خلف - كتاب التبشير في منطقة الخليج العربي.
تَخصّص بالتدريج في بيع الكتب التي تفرّق بين الأديان، ثمّ باشر بنفسه تأسيس مدرسة ومستشفى صغير للتنصير، ثمّ استقدم عدداً من المراسلين والدعاة للتنصير من النساء والرجال الأميركيّين إلى دول الخليج، وخصوصاً البحرين، وقد عرف بجرأته حتّى أنّه استطاع أنْ يقتحم الأزهر ويوزّع منشوره المعروف تحت عنوان(ارجع إلى القبلة القديمة) ولعلّ هذا أحد قرائن ولائه الصهيوني الذي عُرف عنه مؤخّراً.
لقد رأس زويمر عدداً من مؤتمرات التنصير العالميّة التي عُقدت في القاهرة والهند والقدس، وأدلى فيها بتقاريرٍ إضافيّةٍ عن الخطوات التي حقّقتها محاولته في (تنصير المسلمين)، وقد كشف هذا المستشرق في أخطر مؤتمراته، عن فشل مغامرة التنصير خلال ربع قرن، وتراجَع عن دعوته فقال:
إنّه لا يدعو لإدخال المسلم في النصرانيّة، وإنّما يدعو إلى إخراجه من الإسلام، ويقول: لقد صرفنا من الوقت شيئاً كثيراً، وأنفقنا من الذهب قناطير مقنطرة، وألّفنا ما استطعنا أنْ نؤلّف، وخطبنا، ومع ذلك كلّه فإنّنا لم ننقل من الإسلام إلاّ عاشقاً بنى دينه الجديد على أساس الهوى، فالذي نحاوله من نقل المسلمين من دينهم هو باللعب أشبه منه بالجد...وعندي أنّنا يجب أنْ نعمل حتّى يصبح المسلمون غير مسلمين.
إنّ عمليّة الهدم أسهل من البناء في كلّ شيء إلاّ في موضوعنا هذا؛ لأنّ الهدم للإسلام في نفس المسلم معناه هدم الدين على العموم(١) . وقد دعا زويمر إلى توسيع نطاق التعليم التنصيري تحت أسماء أُخرى لخداع المسلمين، ودعا إلى توحيد هيئات التنصير.
لقد كان زويمر متطرّفاً شديد التعصّب ضدّ الإسلام والمسلمين، وقد بلغ به الأمر إلى أنّ يحذّر من أيّ تقارب وتوافق مع المسلمين (فقد هاله أنْ يرى نفراً من
____________________
(١) الجندي، أنور - مجلّة منار الإسلام، العدد ٦، السنة ١١، حرب الكلمة ومخطّطات كرومر، ودنلوب، وزويمر ضدّ الإسلام.
pp. ١٤١ ff
النصارى يدعون إلى مصادقة المسلمين في الصين؛ لأنّ هذه الصداقة في نظره تخلق في نفس النصارى جبناً عن التبشير)(١) .
ونلاحظ من خلال ما تقدّم عن هذا المستشرق المبشّر، أنّ جوهر عمله هو تحقيق غاية الدول الغربيّة الطامحة إلى السيطرة والاستعمار، ولم يكن يخفي في نفسه ذلك، بل إنّه يعتبر أنّ دوره ودور نظرائه لا ينتهي عند حدّ استعمار الشرق، بل لابدّ أنْ يستمرّ لاستدامة هذا الاستعمار وتركيز أرضيّته، فيقول في المؤتمر التبشيري الذي عقد في عام ١٩١١م في(لكناو) بالهند: إنّ خمسة وتسعين مليوناً على أقلّ تقدير من أتباع نبيّ مكّة يتمتّعون اليوم بنعمة الحكم البريطاني(٢) .
وكذلك يؤكّد ما قلناه عنه من رأيه الصريح الذي يفصح عنه بقوله: إنّ الأبواب المفتوحة التي تؤدّي فعلاً إلى الإسلام، إنّما هي المستعمرات التي يعيش فيها المسلمون تحت حكمٍ مسيحي، أو حكمٍ وثني أيضاً (في إفريقيا والهند مثلاً)(٣) ، ويقصد بذلك أنّ عملهم يجب أنْ يبدأ بمرحلته الثانية عندما يستعمرون هذه البلاد، ولا يتركون للإسلام فرصة حياةٍ ووجوداً في واقع المسلمين.
وعندما أخذ المؤتمرون في مؤتمر(لكناو) بالهند يَتَدارسون الأحوال السياسيّة في العالم الإسلامي، خطب زويمر وقال: إنّ الانقسام السياسي الحاضر في العالم الإسلامي دليلٌ بالغٌ على عمل يد الله في التاريخ، واستثارة للديانة المسيحيّة (لكي تقوم بعمل)، إذ إنّ ذلك يشير إلى كثرة الأبواب التي أصبحت مفتّحة في العالم الإسلامي على مصاريعها.
إنّ ثلاثة أرباع العالم الإسلامي يجب أنْ
____________________
(١) عن د. خالدي، مصطفى. ود. فروخ، عمر.
MW. Adr. ٢٨ , pp. ١٠٩ ff
من كتاب (التبشير والاستعمار في البلاد العربيّة): ٣٨.
(٢) عن د. خالدي، مصطفى. ود. فروخ، عمر Islam and Missions في كتاب التبشير والاستعمار في البلاد العربيّة: ١٤٦.
(٣) المصدر السابق: ١٤٦ Islam and Missions
تُعتبر الآن سهلة الاقتحام على الإرساليّات التبشيريّة.
إنّ في الإمبراطوريّة العثمانيّة اليوم وفي غربي جزيرة العرب، وفي إيران والتركستان والأفغان وطرابلس الغرب ومراكش سدوداً في وجه التبشير، ولكن هناك مِئة وأربعون مليوناً من المسلمين في الهند وجاوة والصين ومصر وتونس والجزائر، يمكن أنْ يصل إليهم التبشير المسيحي بشيء من السهولة(١) .
وهكذا نجد زويمر يقوم بدوره الميداني ممهّداً ومنظّراً لحركة الاستعمار في الشرق، حتّى وصل به الأمر أنْ ينصح بريطانيا العظمى أنْ تبدّل سياستها المهادنة في مصر تبديلاً أساسيّاً، وأنْ تشعر المصريّين بقوّة بريطانيا وبنعمها عليهم(٢) . وهذا بكلمةٍ أُخرى ترسيخ الاستعمار بالقوّة والقهر.
ولم يهمل زويمر أُسلوب الإغراء مستفيداً ممّا يُعتبر أحد الأساليب الناجعة، التي مارسها المسلمون لكسب الناس إلى الدين الإسلامي، فقد كتب في المجلّة الاستشراقيّة التي يُحرّرها (العالم الإسلامي) مقالاً عنوانه: (استخدام الصدقات لاكتساب الصابئين)، الذي يبحث فيه كيف أنّ الإسلام على عهد الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أجاز إعطاء الزكاة للمؤلّفة قلوبهم، أي أُولئك الذين دخلوا في الإسلام وكانوا ذوي حاجة وذوي اتّجاه مادّي(٣) ، ويقصد بذلك أنّ استخدام الإحسان المادّي من الأساليب المؤثّرة في طريق التبشير المسيحي، وتحويل الناس نحو النصرانيّة.
وهكذا وفي خاتمة الحديث عن هذا المستشرق الفعّال يمكننا القول: إنّ ما وضعه من خطط وبرامج تبشيريّة واستعماريّة ما يزال العمل بها سارياً حتّى اليوم، خصوصاً من خلال مناهج التعليم والتربية والثقافة في أغلب البلاد الإسلاميّة.
____________________
(١) عن د. خالدي، مصطفى، ود. فروخ، عمر - التبشير والاستعمار في البلاد العربيّة: ١٦٩ - ١٧٠.
Islam and Missions ٢٢.
(٢) المصدر السابق: ١٧٤ ibid ٢٥ f
(٣) عن د. خالدي، مصطفى. ود. فروخ، عمر - التبشير والاستعمار في البلاد العربيّة: ١٩٥.
لويس ماسينيون Louis Massignon ( ١٨٨٣ - ١٩٦٣م)
من أكبر مستشرقي فرنسا، تسنّم مناصب حسّاسة كان لها الدور الكبير في توجّهاته الاستشراقيّة، فقد شغل منصب مستشار وزارة المستعمرات الفرنسيّة في شؤون شمال إفريقيّا، وكذلك الراعي الروحي للجمعيّات للتبشيريّة الفرنسيّة في مصر، ولعلّ العمل الذي شغله(ماسينيون) قد تناسب مع دور فرنسا في تشويه الفكر الإسلامي، مقدمةً وطريقاً لإزالة العقبات عن حركتها الاستعماريّة للشرق الإسلامي، ولهذا اشتهرت بأنّها من أبرز دول أوربّا الغربيّة في مجال إعداد جيش من المبشّرين والمستشرقين، مدرّبين على أحدث وسائل التنصير والتبشير، انتشروا في إفريقيا ودول الشرق الأوسط(١) .
وهذا هو الذي دفع رئيس المجمع العلمي العربي بدمشق (محمّد كرد علي) للقول: إنّنا نرى من واجبنا أنْ يشكّ كلّ عربي وكلّ مسلم، في أكثر ما يصدر من الأحكام من الفرنسيّين على الإسلام والمسلمين؛ وذلك لأنّه ثبت أنّ من الفرنسيّين مَن لا ينظرون إلى كلّ أمر إلاّ بمنظار الاستعمار(٢) . ويؤكّد الكاتب الإسلامي(مالك بن نبي) هذه الحقيقة في دور ماسينيون قائلاً: إنّ ماسينيون قد تفرّغ آخر حياته للتبشير، وقد مدّ وزارة الخارجيّة الفرنسيّة بالمعلومات والتوصيات حول
____________________
(١) المركز الإسلامي للأبحاث السياسيّة في قم، عن كتاب (السياسة الفرنسيّة في الشرق الأوسط): ٥٦.
(٢) د. خالدي، مصطفى، ود. فروخ، عمر - التبشير والاستعمار في البلاد العربيّة: ٢٢١.
البلاد الإسلاميّة، وتهيئة العملاء والكتّاب(١) . ويُساعد على ما ذكرناه الوضع الميداني لماسينيون، فقد زار العالم الإسلامي أكثر من مرّة، وخدم بالجيش الفرنسي خمس سنوات في الحرب العالميّة الأولى، وكان عضواً بالمجمع اللغوي المصري، خمس سنوات في الحرب العالميّة الأولى، وكان عضواً بالمجمع اللغوي المصري، وكذلك عضواً في المجمع العلمي العربي في دمشق، و(تعاون مع النظام الاستعماري الفرنسي في المغرب، وعبّر عن مواقفه الاستعمارية علانية)(٢) .
أمّا التوجّهات العلميّة لماسينيون في العلوم الاستشراقيّة، فقد تعلم اللغات: العربيّة والفارسيّة والتركيّة والألمانيّة والانجليزية، وعني بالآثار القديمة، وأدّت مشاركته في التنقيب عنها بالعراق (١٩٠٧ - ١٩٠٨م) إلى اكتشاف قصر الاخيضر.
درّس تاريخ الاصطلاحات الفلسفيّة بالعربيّة في الجامعة المصريّة القديمة (١٩١٣م) واستهواه التصوّف الإسلامي فكتب عن (مصطلحات الصوفيّة)، و(أخبار الحلاّج) ونشر (ديوان الحلاّج) مع ترجمته إلى الفرنسيّة، وكذلك نشر(الطواسين) للحلاّج، وكتب عن (ابن سبعين) الصوفي الأندلسي، وعن (سلمان الفارسي) وتظاهر بالدعوة إلى فكرة توحيد الديانات الكتابيّة الثلاث.
نشر (منتخبات من نصوصٍ عربيّة خاصّة بتاريخ الصوفيّة في الإسلام) وتولّى تحرير (مجلّة العالم الإسلامي) الفرنسيّة التي سمّيت فيما بعد بـ (مجلّة الدراسات الإسلاميّة) وأصدر بالفرنسيّة أيضاً (حوليات العالم الإسلامي) من سنة ١٩٢٣م الى سنة ١٩٥٤م، وكتب كثيراً في (دائرة المعارف الإسلاميّة) عن القرامطة والنصيريّة والكندي وفلسفة ابن سينا وأمثال ذلك. وكتب كذلك (تاريخ
____________________
(١) ابن نبيّ، مالك - شاهد القرن الطالب.
(٢) د. ابن عبود، محمّد - مجلّة العالم، العدد ٢٩٤، المساهمة الإيجابيّة لحركة الاستشراق لا تنفي تعصّب بعض المستشرقين ضدّ الإسلام.
العلم عند العرب) في (دائرة المعارف الممتازة)، التي صدرت بباريس (المجلّد الأوّل سنة ١٩٥٧م)(١) .
وممّن تأثّر به ماسينيون تأثّراً كبيراً هو المستشرق اليهودي النمساوي (أغناس غولد صيهر)، الذي حاول أنْ يثبت أنّ الحديث النبوي كلّه موضوع في عهود لاحقة لعهد الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وذلك في كتابه (دراسات إسلاميّة)، كما اعتبر الدين الإسلامي نسخة مشوّهة للديانة اليهوديّة والمسيحيّة، حيث عبّر عن ذلك بوضوح في قوله: لا يهمّنا من وجهة نظر التاريخ الثقافي أنْ لا تكون تعاليم محمّد ناتجة عن إبداع عبقريّته التي جعلته نبيّاً لدى شعبه، وإنّما المهم أنّه أخذ جميع تعاليمه من اليهوديّة والمسيحيّة(٢) .
وبالتالي فإنّ ماسينيون أخذ كثيراً من تعاليم هذا المستشرق اليهودي، وبدت واضحة على كتاباته وشروحه التي نشرها في أكثر من كتاب، فمثلاً كان ماسينيون يُركّز على المعارف الفلسفيّة والصوفيّة الشاذّة والسيّئة، كالتي كتبها في دائرة المعارف الإسلاميّة تحت مادّة (الشطح) كقول البسطامي: (سبحاني، سبحاني، إنّ لوائي أعظم من لواء محمّد، طاعتك لي يا رب أعظم من طاعتي لك)(٣) .
إنّ ماسينيون قد وضع ووظّف جُلّ معارفه الاستشراقيّة في خدمة الأهداف الاستعماريّة، وفي مقدّمتها التبشير للنصرانيّة، ويتّضح هذا في أكثر من دليل، منها زعمه أنّ المسلمين يعتقدون في شأن عيسى بن مريم على ما جاء في القرآن، ومن أجل ذلك يرجو أنْ توجّه الجهود إلى جعلهم يعتقدون بعيسى بن
____________________
(١) الزركلي، خير الدين - الأعلام (قاموس تراجم) ٥: ٢٤٧.
(٢) د. ابن عبّود، محمّد - المساهمة الإيجابيّة لحركة الاستشراق لا تنفي تعصّب بعض المستشرقين ضدّ الإسلام. مجلّة العالم، العدد ٢٩٤.
(٣) الجندي، أنور - أخطاء دوائر المعارف والموسوعات العالميّة، مجلّة (منار الإسلام)، العدد ٦، السنة ١١.
مريم نفسه، ولكن باسمه المسيحي(١) .
ولا شكّ في أنّ ماسينيون يدرك جيداً أنّ نظر المسلمين ونظر النصارى إلى عيسى بن مريم مختلفان، إلاّ أنّه كان يُريد أنْ يُغري المبشّرين لاستثمار أيّ تشابه يُمكن أنْ يكون مدخلاً للتأثير على المسلمين وتحويلهم إلى النصرانيّة، أو على الأقل القبول ببرامجها التثقيفيّة ومناهجها التعليميّة التي تكون طريقاً لربط المسلمين بالإيديولوجيّة الاستعماريّة لأوربا النصرانيّة.
وممّا تميّز به ماسينيون هو عدم اكتفائه بطبقة المتعلّمين في التبشير، بل راح يُنظّر لطريقة التبشير في وسط الأُمّيين، ومارس ذلك بنفسه رغم أنّه أُستاذ جامعة في باريس ومستشار وزارة المستعمرات الفرنسيّة، وخلاصة طريقته كانت الاتّصال المباشر بالأمّيين وطرح الأفكار والمفاهيم المسيحيّة من خلال الإشارات الكليّة الواردة في القرآن الكريم، أو من خلال مفاهيم الإسلام المرتكزة في الوسط العام للاميّين. فمثلاً كان يدعو في إحدى مقالاته أنْ يعود الاعتقاد الإسلامي في رجوع عيسى بن مريم فيتّفق مع الحادث الثاني للمسيح النصراني الذي يعمل المهدي العربي على انتصاره(٢) .
ويقصد بذلك أنّه مادام لدى المسلمين أخبار برجوع المسيح عيسى بن مريم، فلماذا لا يكون هذا المسيح الراجع هو المسيح الذي يعتقد به النصارى اليوم؟ وبعبارة أُخرى أنْ يعود المسلمون عن قولهم عيسى بن مريم، إلى القول عيسى ابن الله، إذن فليؤمن به المسلمكون ويتحوّلوا إلى عقيدة النصارى. وكانت هذه الطريقة أحد أساليبه التي اعتقد بأنّها ستكون فعّالة لتحويل المسلمين عن دينهم، وبالتالي
____________________
(١) عن د. خالدي، مصطفى. ود. فروخ، عمر - كتاب التبشير والاستعمار في البلاد العربيّة: ٤٤.
L, Islam et I, occident ١٦٤.
(٢) عن د. خالدي، مصطفى. ود. فروخ، عمر - كتاب التبشير والاستعمار في البلاد العربيّة: ٨٣.
L,Islam. Et L, occident (les cahiers du sud ١٩٤٧ ) p. ١٦٤.
يسهل استعمارهم على دول أوربّا.
ومن أساليب(ماسينيون) التي دبّج لها المقالات الطوال، هي ضرورة تشجيع الشرقيّين للدراسة في أوربّا وأميركا، وذلك للتأثير عليهم عن طريق ضخّهم في أجواء وأساليب الحياة الأوربيّة، في التفكير والعلم والسلوك، ليكون ذلك أرضيّةً مناسبةً لتطويعهم للفكر الاستعماري الأوربّي، وبالتالي توظيفهم في خدمة أهدافهم في تطويع بلدانهم الشرقيّة لأوربّا المستعمِرة، وفي هذا يقول ماسينيون لنظرائه الأوربيّين: إنّ الطلاب الشرقيّين الذين يأتون إلى فرنسا يجب أنْ يلوَّنوا بالمدنيّة المسيحيّة(١) .
ولعلّ من أبرز مصاديق هذا التوجّه لدى ماسينيون هو عنايته الفائقة ببعض هؤلاء الطلبة، مثل (ميشيل عفلق) مؤسّس حزب البعث العربي الاشتراكي ومنظّره الفكري، الذي قال عنه ماسينيون: إنّه أنبغ وأعزّ تلميذ في حياتي(٢) . وقد أظهرت عناية ماسينيون بميشيل عفلق بوضوح آراء التلميذ الفلسفيّة ومواقفه الخاصّة ومدى انتمائه للفكر الأوربّي الصليبي، وترجمته الحرفيّة لتعاليم الدين الكنيسي ومضامينه الفلسفيّة، ولعلّ أبرز وأخطر ما طرحه (عفلق) وأسّس عليه فكر حزب البعث العربي الاشتراكي هو مقولته المعروفة(٣) :(الإيمان قبل المعرفة) (٤) .
وهي مقولة نصرانيّة محضة أفرزتها المدرسة الكنيسيّة، وتوصّل إليها عقلها اللاهوتي بناءً على قواعد وأُسس القدّيس أوغسطين، التي جاءت لسدّ الثغرة الفكريّة القائمة بين فكرهم اللاهوتي والعقل، المتمثّلة بمسألة التعقيد والنقص
____________________
(١) عن د. خالدي، مصطفى، ود. فروخ، عمر - التبشير والاستعمار في البلاد العربيّة: ٨٩.
Evue (Dieu Vivant) No. ٤ , pp. ٧ ss
(٢) بلوط، عليّ - إعدام البعث - مجلّة الدستور اللبنانيّة.
(٣) كاظم، فؤاد - آراء وأرقام حول نظام البعث في العراق: ٨٥.
(٤) عفلق، ميشيل - في سبيل البعث: ٤٥.
في إدراك الثالوث المقدّس(١) .
وينظّر عفلق مقولة: (الإيمان قبل المعرفة) التي استقاها من أُستاذه ماسينيون مكوّناً منها الفكر القومي، الذي بنى عليه إيديولوجيّة حزب البعث العربي الاشتراكي، فيقول: (... إنّنا نُريد أنْ نعرف مَن قَبِل بنا، ويؤثّر على غيرنا من مجرّد سماع نبرات صوتنا، ومشاهدة حركتنا العاديّة وسلوكنا اليومي، نُريد أنْ نعرف الذين يدركوننا بالغريزة، أيّ هواء صافٍ نستنشق، أيّ جوٍّ نزيهٍ نحيا، دون أنْ نحتاج للبراهين والعلم والإثبات والأرقام...)(٢) .
وممّا عُرف عن ماسينيون أنّه كان زعيم الحركة الرامية إلى الكتابة بالعاميّة وبالحرف اللاتيني، التي تبنّاها الفرنسيّون في الشرق الإسلامي، وركّز بدعوته هذه على المغرب ومصر وسورية ولبنان، وممّن استجاب لدعوته في هذا المجال الأب(رافائيل نخلة) حيثُ ألّف كتاباً تحت عنوان (قواعد اللهجة اللبنانيّة السوريّة)، وهو موضوع باللغة الفرنسيّة، والنصوص العربيّة منسوخة بالحرف اللاتيني.
واستجاب أيضاً لهذه الدعوة (شكري الخوري) الذي ألّف كتاب (التحفة العاميّة في قصّة فنيانوس) التي نشرها الأب لاي اليسوعي، واستجاب كذلك (الخوري مارون غصن) أحد المدرّسين في مدرسة (عين طور) في لبنان، وقد ألّف كتاباً ذا عنوانين ومضمون عامي تحت اسم (في متلو هلكتاب)(٣) .
أي (هل يوجد مثل هذا الكتاب) وأمثال هؤلاء كثيرون، والهدف من هذه الدعوة واضح، حيث إنّ ضياع اللغة الفصحى، وحصر دائرة تداولها سوف يُساهم في الحجر على مفاهيم القرآن اللغوية وبياناته البلاغيّة، وكذا الحديث الشريف وكتب المعارف الإسلاميّة
____________________
(١) كاظم، فؤاد - آراء وأرقام حول نظام البعث في العراق: ٨٥.
(٢) عفلق، ميشيل - في سبيل البعث: ١.
(٣) د. خالدي، مصطفى، ود. فروخ، عمر - التبشير والاستعمار في البلاد العربيّة: ٢٢٤.
وتراثنا العلمي الثري، وبدون اللغة العربيّة الفصحى تُفقد لغة العلم والمعرفة الإسلاميّة لتحلّ محلّها تدريجيّاً اللغة اللاتينيّة، التي تكون مدخلاً للمعارف الأوربيّة نصرانيّةً كانت أم علمانيّة، وهكذا نجد ومن خلال هذه الإلمامة المختصرة عن المستشرق ماسينيون، أنّه بذل جهوداً كبيرة على الصعيدين الفكري والميداني لربط الشرق الإسلامي بالعَجَلَة الأوربيّة، وأساليب متنوّعة كان أبرزها تربية نماذج متميّزة من تلامذته في الجامعات الفرنسيّة، بهدف إعدادهم رجال فكر في الشرق على الطريقة الأوربيّة.
وقد أشرنا إلى واحد من تلك النماذج، وهو ميشيل عفلق الذي برَز أحد روّاد فكرة البعث القومي العربي في الشرق.
هذه إلمامة سريعة بنماذج منتقاة من كبار رجال الغرب المستشرقين كانوا روّاد تنظير ومَنْهَجَة، ومراكز إدارة، وإعداد لعمل أكثر من اهتمّوا بالشرق الإسلامي، تطرّفاً وحركةً باتّجاه الأهداف التبشيريّة والاستعماريّة لأوربّا.
وقد سِيقت هذه النماذج مثالاً بارزاً يكشف عن دوافع عملهم الحقيقيّة، وطريقتهم المتعصّبة في التفكير، وأساليبهم الخبيثة في تشويه الإسلام ومجتمعاته، ومدى ارتباط ذلك بحركة الاستعمار الغربي للسيطرة على الشرق الإسلامي.
الفصل السّادس
نماذج من الدّسّ والتّشويه في الإنتاج الموسوعى للمستشرقين
* دوائر المعارف (البريطانيّة، الأميركيّة، لاروس الفرنسيّة).
* الموسوعة العربيّة الميسّرة.
* قاموس المنجد.
* الموسوعة الإسلاميّة الميسّرة.
* دائرة المعارف الإسلاميّة.
* هويّة وخلفيّة أبرز كتّابها.
* الدّسّ والتّشويه في موادّها (شُبهات وردود).
* ذكاء محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وخياله عماد دعوته.
* تناقض القرآن والتّردّد في بعض آياته.
* تأثّر محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) باليهوديّة والنصرانيّة والجاهليّة، واستقاؤه منها في صياغة قرآنه ودينه الجديد.
* شعائر الإسلام وليدة إبداعات وتأثيرات متنوّعة.
* غموض العديد من مقولات النّبيّ محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) القرآنيّة.
* ادّعاء النّبيّ محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وابتكاره واصطناعه وتأثّره بمن حوله.
إنّ تأسيس ثقافة الشرق وتنظير الرؤى العلميّة عنها في مختلف مجالات المعرفة الإنسانيّة، على أُسس منهجيّة تخدم أهداف الغرب وحركته الاستعماريّة في الشرق الإسلامي، من أبرز ما اهتمّ به المستشرقون، خصوصاً في إنتاجهم الموسوعي، وقد تفنّنوا في ذلك بأساليبٍ مختلفة، فهم في الوقت الذي أضفوا على ظاهر دراساتهم الموسوعيّة تلك الصبغة العلميّة والمنهجيّة التحقيقيّة، انتهجوا سبيل الدسّ الخفيّ والتركيز على المنقولات الشاذّة والمقولات الغريبة، وتجميع ما من شأنه تشويه الحقائق وتحريف الواقع في موارد أساسيّة وحسّاسة، من شأنها أنْ تشكّك في أُصول الدين الإسلامي وتاريخ المسلمين وسيرة نبيّهم الكريم.
هذا إضافةً إلى أنّ المنطق العلماني وخلفيّتهم العدائيّة للإسلام، وكلّ ما ينتمي له من مجتمعات وتاريخ وتراث حضاري، سوف تتحكّم في كتاباتهم وتنظيراتهم تلك، وهم بذلك يرمون إلى تحقيق هدفين رئيسيين:
الأوّل: تأسيس ثقافة الشرق الإسلامي على ضوء النظرة الغربيّة، الهادفة إلى تركيز الاتّجاه العلماني ومنطقه في تناول المعارف والعلوم الإنسانيّة، وبالتعبير الاصطلاحي تغريب ثقافة الشرق الإسلامي، وهُم بذلك يجرّدون المعارف الإسلاميّة وثقافة المسلمين وتراثهم الحضاري من خصوصيّاته الذاتيّة، وصبغته الخاصّة المعبّرة عن انتمائه للوحي والرسالة الإلهيّة.
الثاني: خلق الأرضيّة وتشييد أُسُس وعوامل علمنة الشرق الإسلامي ثقافيّاً ومنهجيّاً، واستعماره سياسيّاً وحضاريّاً، من خلال اعتماد الثقافة والمناج المغرّبة في الجامعات والمعاهد المؤسّسة بهدف تربية جيل المثقّفين وساسة الشرق
المرتقبين لقيادة وإدارة الحكم في بلدانهم، على أساس المنهج الغربي وطريقته في احتواء الشعوب والمجتمعات وبالتالي تحقيق أعلى رتب الاستعمار الحضاري للشرق الإسلامي.
وللسير الحثيث نحو هذين الهدفين وتحقيقهما على أرض الواقع، بشكلٍ جذريٍّ ومؤثّر، عمدوا إلى التعظيم العلمي والمبالغة الإعلاميّة بقيمة إنتاجاتهم الموسوعيّة، وطرحوها على أنّها المصادر الوحيدة في التناول الشّمولي والمَنْجَة العلميّة للمعارف الإسلاميّة، على أُسُس الاستقصاء الموثّق والتحقيق المُمنهج، وبذلك صرفوا أنظار طلاّب المعرفة والثقافة المعاصرين عن الأُصول التقليديّة، والمصادر الأوليّة التي زخرت بها مكتبات الشرق الإسلامي، واحتوتها خِزانات التراث العلمي للمسلمين، حتّى أصبحت هذه الأُصول والمصادر - في نظر هؤلاء الطلاّب - جزءاً من أحجار المتاحف وآثار التاريخ التي لا تعدو أنْ تكون تعبيراً عن الماضي الذي طوي وطويت معه قيمته المقترنة به... وقد أدّى هذا الإعلام والتعظيم إلى اعتماد هذه الموسوعات مراجعَ علميّةً وثقافيّةً للدراسات الجامعيّة الحديثة ولمناهج دروسها المقرّرة.
ومن أبرز نماذج موسوعات المستشرقين التي استُهدفت فيها حقائق الإسلام بالدسّ والتشويه وتاريخ المسلمين وسيرة النبي الكريم محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بالتحريف هي:
دوائر المعارف (البريطانيّة، الأميركيّة، لاروس الفرنسية)
وهي من دوائر المعارف الغربيّة المترجمة إلى اللغة العربيّة، والتي تعتبر من أخطر أعمال التغريب والغزو الثقافي، التي قامت على أساس معطيات الجهد الاستشراقي والتبشيري، اللذين سارا معاً في خدمة هدفٍ واحدٍ وهو القضاء على الإسلام، عن طريق تشويه معالمه وحرفِ مفاهيمه بالشكل الذي يُناسب أهدافهم الخبيثة، والدسّ فيه بما يُخالف الواقع والحقائق من روايات كاذبة وشخصيّات مزيّفة لا وجود لها، والتهجّم والافتراء على الشخصيّات المقدّسة والرموز العظيمة من رجالات الإسلام.
ومن الأمثلة على ذلك، هو عندما تقدّم هذهِ الدوائر للقارئ مادّة (إسلام) ومادّة (محمّد) ومادّة (قرآن)، حسب التصنيف لهذه المفردات الّتي تتّبعها هذه الدوائر، تقدّمه على النحو الذي قدّمته دوائر الاستشراق والتبشير في القرن التاسع عشر، ولم تتحوّل عنه رغم التغييرات الإيجابيّة، التي طرأت على الفكر الغربي في نظرتهِ إلى الإسلام ومفاهيمه الحقيقية، ورغم العديد من الدراسات والكتابات، التي صحّحت بعض الشيء أفكار ومقولات المستشرقين والمبشّرين، القائمة على التعصّب الديني، والحقد ضدّ الإسلام والمسلمين، والتي كانت سائدة لديهم ومعتمدة عندهم طيلة القرون المنصرمة، ككتابات برناردشو، وداربر، وغوستاف لوبون... وغيرهم.
أمّا نماذج نصوص تلك المواد فمنها ما أوردتهُ دائرة المعارف البريطانيّة عن مادّة (إسلام) حيث تدّعي فيها أنّ الإسلام مأخوذ من المسيحيّة واليهوديّة، وأنّ
الرسول لم يُهاجر ولكنّهُ هرب من مكّة...
وأمثال هذهِ الافتراءات الّتي يحاولون من خلال طرحها، إفراغ فكرة النبوّة والرّسالة الّتي يؤمن بها المسلمون، من مفهوم ارتباطها بالغيب والوحي الإلهي، أو الانتقاص من مقام الرسول وقدسيّته على الأقل، وهم بذلك يوهمون مَن يقرأ ويراجع هذهِ الدوائر، بأنّ الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إنّما يتصرّف بوحي ذاته، وليس هناك ارتباط بينهُ وبين السماء عن طريق الوحي، وأنّه شخصٌ عادي لا يتميّز في خصاله وملكاته عن غيره.
وللأسف فقد تسلّلت هذهِ المفاهيم المحرّفة إلى دراسات المسلمين أنفسهم وكتاباتهم، فأخذ بعضهم يردّد عند بحثه للتاريخ الإسلامي، وبالخصوص مقاطع حياة الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله وسلّم) نفس ما يردّدهُ المستشرقون والمبشّرون، من روايات كاذبة ومقولات مدسوسة، رغم أنْ هذهِ الافتراءات والدسائس تتناقض بشكلٍ صارخ، والثوابت التأريخيّة الّتي أقرّتها الدراسات الأوربيّة وأقلام مفكّريها، دفعت بعضهم مؤخّراً إلى الاعتراف بالإسلام كدين سماوي.
ومن الملاحظ على المصادر التي اعتمدتها هذهِ الدوائر في معارفها، أنّها مصادر متأخّرة زمنيّاً عن زمن الوقائع التأريخيّة، وأنّها ضعيفة ومهملة بلحاظ القيمة العلميّة لها، إضافةً إلى مجهوليّة نصوصها وانقطاع سندها، وهي بذلك لا تعبّر إلاّ عن الرأي الاستشراقي الأوربّي بالنسبة لهذهِ المواد، خصوصاً المفردات المتعلّقة بالإسلام (عقيدةً وحضارة)، فإنّ للاستشراق موقفاً من ذلك يتمثّل (بمحاكمة الإسلام إلى مفهوم الدين في الفكر الأوربي) ( Belgon ).
ذلك المفهوم المفرَغ مِن أهمّ المعاني والمبادئ الأساسيّة للدين، وهو المفهوم العلماني للدين في أوربّا، والذي يعني - عندهم - الطقوس والعبادة الكهنوتيّة، فالدين في المفهوم العلماني الأوربّي علاقةٌ بين الله وذات الإنسان فقط، وحتّى هذهِ العلاقة لم تسلم من التحريف، ولم تؤخذ مأخذاً حقيقيّاً ينعكس على أخلاقهم وسلوكهم وطريقة تعاملهم، وليس كذلك مفهوم الدين في الإسلام الجامع للعلاقتين بين الله والإنسان، والإنسان
والإنسان، في السلوك الفردي والاجتماعي وعلى صعيد الحكم والدولة. وهذا مغمزٌ أساسي آخر من مغامز هذا البحث، يحول دون استيعاب جوانب الإسلام المختلفة على حقيقتها.
وقد عُرف عن أغلب المستشرقين، خصوصاً الكتّاب في دوائر المعارف الغربيّة والعاملين فيها، تعصّبهم لوجهة نظر مزودجة:
الأُولى: وجهة نظرهم إلى الدين النصراني الذي يدّعون الإيمان به، وعليه فهم لا يُقرّون بوجود دينٍ غيره أو بعده، رغم أنّ بعض دراساتهم تضمّنت إقراراً بذلك، كما صرّحَ بهِ بعضهم من خلال اعترافِه بالإسلام وتدوينه ديناً سماويّاً خاتماً للأديان في بعض الكتب الغربيّة، مثل ترجمة معاني القرآن لـ(مونتيه)، والتي تتميّز بأنّها قريبةً إلى الصحّة، وإنْ كانت لا تخلو من الشوائب وبعض الأخطاء.
الثانية: النزعة الاستعلائيّة (الاستكباريّة) من زاوية المفهوم الاجتماعي والسياسي الذي يحكم فلسفة الحضارة الأوربيّة كلّها، والنفوذ الاستعماري الأوربّي في بلاد الإسلام، وكلّها عوامل تمنع من الإقرار والاعتراف بالإسلام بعيداً عن التعصّب الديني والعداء السياسي، لذا، ومن خلال هذا التعصّب والعداء والفهم الناقص والنظرة العمياء، نرى أنّ مادّة (الإسلام) في دائرة المعارف البريطانيّة لعام (١٩٨٠م) قد جاءت مليئةً بالافتراءات والأخطاء عن سوء الفهم المقصود أو عن الجهل المركّب.
ونفس الملاحظة نجدها في عرْضهم لسيرة النبيّ الكريم محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، حيث أنّهم يردّدون ما ردّدهُ الاستشراق والتبشير، خصوصاً ذلك الذي ثَبَتت صلتهُ الواضحة بمصدريّه الخطَيرَين، الكنيسة ووزارة المستعمرات في الدول المستعمِرة للعالم الإسلامي (بريطانيا، فرنسا، هولندا)، وكذلك ما ردّدهُ الاستشراق الصهيوني والماركسي، كما في كتابات (اللورد
كرومر) والوزير الفرنسي (هانوتو)(١) .
هذهِ الكتابات والمؤلّفات مليئة بالأخطاء، وهادفة إلى تصوير الدين الإسلامي والحضارة الإسلاميّة، على أنّها غير قادرة على إثبات وجودها واستعادة مكانتها الحقّة، لهذا نجد أنّ دوائر المعارف هذهِ لا تفرّق بين مفهوم التوحيد والنبوّة كما هو في الإسلام والأديان الأُخرى، ولا تفرّق بين الإلوهيّة والنبوّة وبين الرسل والصحابة، كما نجدهم عاجزين عن فهم المعجزات وفلسفتها وفهم فكرة وحدة الأديان وتدرّجها الهادف نحو الكمال.
ونجدهم يُخضعون النظريّة الشموليّة للإسلام، التي تجمع بين المادّة والروح في نظرتها للحياة والإنسان، لمنهج تفسيرهم المادّي المحض للحياة والإنسان، فهم بذلك يبدأون عند تناولهم للإسلام من فكرةٍ مسبقة، ينظرون من خلالها في أبحاثهم ودراساتهم، ويحاولون اقتناص النصوص والروايات الّتي تؤيّد فكرتهم تلك، وإنْ كانت غير مُسندة وساقطة عن الاعتبار، أو ضعيفة معروضٌ عنها، أو شاذّةٌ مهملة، ويُعرضون عن تلك التي تُخالفها وإنْ كانت متواترة أو موثوقة الإسناد ومعتبرة.
____________________
(١) الجندي، أنور- مجلّة منار الإسلام، العدد ٦ السنة ١١.
الموسوعة العربيّة الميسّرة
وهي الترجمة الحرفيّة لدائرة معارف جامعة كولومبيا، التي وضعت تحت إشراف علماء صهاينة وترجمها شفيق غربال وكوكبة من الباحثين(١) ، وأضافوا إليها المواد الإسلاميّة العربيّة، وقد ترجمت وأُعدّت دون تقدير للتاريخ الإسلامي وحقائقه. ولو تتبّعنا محتويات هذه الموسوعة بنظرة علميّة فاحصة لوجدنا بوضوح سلبيّات أساسيّة في منهجها وموادّها، ويمكننا إجمالها في جانبين:
الجانب الأوّل: بُعدها عن ثوابت التاريخ الإسلامي، وعدم أمانتها في نقل الكثير من حقائقه ومقولاته المعتبرة، حيث نجدها كثيرة الخلط فيما تورده من معلومات مغرضة في اعتمادها على الشاذّ الساقط من الروايات والمصادر.
الجانب الثاني: عدم انطلاقها في تناول الموضوعات وتنظيم المعلومات من حاجة الكتّاب والباحثين الإسلاميّين، لعدم اعتنائها بوجهة النظر الإسلاميّة.
ومن الأمثلة الواضحة على وجود هذين الجانبين السلبيّين في منهجها ومادّتها ما يلي:
١ - تنكّرها وإسقاطها للسنة الهجريّة والتاريخ الهجري، في كلّ ما تتناوله من موادّ ومفردات، خصوصاً ما يتعلّق منها بعصر النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وما بعده من العصور.
____________________
(١) الجندي، أنور - مؤلّفات في الميزان - مجلّة منار الإسلام - العدد ٦ السنة ١١.
٢ - طريقة ومستوى عرضها للموادّ والمفردات الإسلاميّة جاء ضعيفاً للغاية، حيث نجده بسيطاً عاديّاً إلى أبعد الحدود، فاقداً للدقّة والسعة والعمق المطلوب في تلك المواد والمفردات، ممّا يسلبها الحيويّة الموضوعيّة والقيمة العلميّة، ففي عرضهم للموادّ الخاصّة بالإسلام نجدهم يصوّرونها بشكلٍ مدرسيٍّ بدائيّ، وبمستوى سطحي ساذج وغير دقيق لا يخرج القارئ منه بنتيجة ذات قيمة علميّة وإحاطة واقعيّة، كما في مادّة (صلاة) ومادّة (صوم) ومادّة (شريعة)، حيث اقتصر في الأخيرة - مثلاً - على ثلاثة أسطر مقتضبة جاء فيها: (أطلقت قديماً على كلّ ما يشتمل عليه الإسلام من عقائد وأحكام عمليّة، وخصّصت الآن بمجموعة الأحكام الشرعيّة العمليّة المستنبطة من الكتاب والسنّة، أو الرأي والإجماع).
وفي مادّة (الإسلام) نجده يخلط كثيراً ويتجاوز الواقع والحقائق، فمثلاً يقرّر فيها أنّ المذاهب الإسلاميّة لم يبقَ منها اليوم إلاّ أربعة، ويعزو سبب ذلك إلى القصور العلمي للمسلمين، فقد جاء في أحد مقاطع المادّة ما نصّه:
(... وما هو إلاّ قليل حتّى ظهرت المذاهب، التي تُعدّ بالعشرات في الفقه الإسلامي وأُصوله، وإذا كان قد بقي منها أربعة، فما ذلك إلاّ لكثرة أتباعها وانتشار زعمائها في أرجاء الأرض، وكذلك لتقصير المسلمين في النظر، وقصورهم عن اللحاق بشأو الأقدمين في العلم).
وفي مواطن أُخرى من نفس المادّة يُحاول بشكلٍ أو آخر، أنْ يعطي للبعد القومي الدور الأساسي في الفتوحات الإسلاميّة، وما انتشار الإسلام إلاّ أثرٌ عرَضي لها، كما في المقاطع التالية:
( .. وفي موجة تالية زحفت الجيوش العربيّة إلى جنوب فرنسا (غاليا)، ولكن توقّفت الفتوح عند مدينةتور - پواتيه .. صاحَب هذا التوسّع العربي السريع ظاهرة انتشار الإسلام في الأقطار المفتوحة، وانتقال اللغة العربيّة إليها، وفي الوقت الذي كان فيه العرب ينسحبون من الأندلس، استولى العثمانيّون (بعد تأسيس دولتهم القويّة بآسيا الصغرى) على ملك البيزنطيّين في أوربّا... وفي أثناء الحكم العثماني للبلدان الأوربيّة التي سقطت
بأيديهم، اعتنق كثير من السكّان الدين الإسلامي...) .
هذا في حين نجده في موادّ ومفردات عامّة أُخرى يتوسّع ويتعمّق بشكلٍ متميّز ومتكلّف أحياناً. فلو قارنّا بين مادّة (مسجد) ذات الخصوصيّة الإسلاميّة ومادّة (مسرح) كمادّة عامّة، نجد أنّ مادّة (مسجد) قد كتب عنها خمسة عشر سطراً فقط، أمّا مادّة (مسرح) فقد كتب عنها مِئة وسبعين سطراً.
أمّا لو كانت الموادّ والمفردات ممّا تخدم أغراضهم وأهدافهم الخاصّة، فيبذلون عناية فائقة في إبراز وجهات نظرهم بها، وإنْ خالفت حقائق ثابتة يقول بها غيرهم، كما في الموادّ التي تتعلّق بفلسطين وتاريخ الأديان، حيث جاءت تفصيلاتها مفعمة بوجهة النظر اليهوديّة والتبشيريّة(١) .
٣ - تعرض الموسوعة، وبكلّ صراحة، وجهة نظر اليهود في مختلف المسائل والموادّ خصوصاً في تلك التي تتميّز بالطبيعة الدينيّة الحسّاسة، بل نجدها تحمّل القارئ فيها وجهات نظرهم تلك، دون أنْ تعرض إلى جانبها وجهات النظر الأُخرى، كما في المسائل والموادّ التي تتعلّق بفلسطين، فهي تفرض فيها مفاهيم خطيرة لا تتّفق والحقائق التاريخيّة، فمثلاً تُصوّر أنّ عصور ازدهار فلسطين وتوحي بأنّ حريّة الحجّ المسيحي لها إنّما كان في ظلّ سيطرة الصليبيين، فيقول في مقطع من مادّة فلسطين:
(... ولمّا أعتلى قسطنطين الأوّل العرش صارت فلسطين كعبة يحجّ إليها المسيحيّون، وازدهرت البلاد في عهد يوستنيان).
وفي مواضع أُخرى من نفس المادّة تضع العرب والأتراك كأقوام وليس كمسلمين قبال المسيحيّين واليهود، وتُنسب المواقف والأحداث إليهم بعنوانهم القومي لا الإسلامي، ومن نافلة القول بيان الهدف السياسي من وراء ذلك، ومن أمثلة ذلك ما جاء في المقاطع التالية: (.. وفي القرن السابع دخلت في حكم العرب، وفي القرن
____________________
(١) انظر مادّة (فلسطين) ومادّة (دين) من الموسوعة.
التاسع امتلكها الفاطميّون... خلّص العرب الأماكن المقدّسة من أيدي الصليبيّين، وحكموا فلسطين حتّى ١٥١٦م، حينما وقعت في قبضة سليم الأوّل سلطان تركيا... وفي ١٩٢٠م استولى البريطانيّون - الّذين كانت فلسطين قد وقعت في قبضتهم في الحرب العالميّة الأُولى - على البلاد، وأعلنوا عزمهم على تخصيصها لإقامة وطن قومي لليهود، فجرت اشتباكات بين العرب واليهود في الفترة (١٩٢٠ - ١٩٣٩م) من جرّاء مقاومة الوطنيّين العرب لسيطرة اليهود على بلادهم، وشرائهم أراضيهم) وهكذا في مقاطع أُخرى.
والشيء نفسه نجده في مادّة (يهود) و(يهوديّة)، حيث تعتمد هذه الموسوعة في بيان هذه المادّة وعرضها على الإسرائيليّات، والروايات الّتي توردها المصادر غير المعتمدة والكتب غير العلميّة.
٤ - ومن عجائب هذه الموسوعة، هو أنّ باب الأديان والعقائد المليء بالخلط والتزوير، تمّ تحريره تحت إشراف أسماء كتّاب وباحثين عرب، كالدكتور إبراهيم مدكور، والدكتور أحمد فؤاد الأهواني وغيرهما، إمعاناً في التشويش على القارئ، في حين نجد كتّاباً مسلمين وعرباً حرّروا فصولاً أُخرى من الموسوعة، لم تُذكر أسماؤهم في المقدّمة.
وفي ختام هذا الاستعراض الإجمالي السريع للأخطاء والتشويش الذي احتوته هذه الموسوعة، نشير إلى أنّ الأُستاذ علي جواد الطاهر قد أحصى على موادّها (٣٧٠) خطأً تاريخيّاً، يَجده مفصّلاً من أراد التوسعة في بحثٍ شامل نشره في مجلّة المجمع العلمي بدمشق عام ١٩٦٩م.
قاموس المنجد
اشتمل هذا القاموس - أوّل صدوره - على قسمين أو قلْ قاموسين:
الأوّل هو قاموس للألفاظ اللغويّة، وهذا عليه مآخذ كثيرة، أهمّها عدم اعتماده على الشواهد والدّلالات اللغويّة الواردة في القرآن الكريم إلاّ نادراً، باعتباره أبرز مصدر يُعتمد لُغويّو العرب عليه، لكونه جاء بأبلغ وأفصح لغتهم في ظرفٍ بلغوا القمّة في ذلك.
والثاني هو قاموس أُطلق عليه (معجم الآداب) إعداد(فردينال نوكل) وهو القاموس الحافل بالأخطاء والشبهات والذي عرضَ له العديد من الباحثين وكشفوا عن أخطائه، حتّى إن أحدهم(١) أحصى فيه أربعمِئة خطأ شائع - تاريخي وعلمي - وأحصى آخر(٢) مِئة خطأ - تاريخي وجغرافي - من الأخطاء الصارخة، وعند استقصاء المصادر التي اعتمد عليها مؤلّف القاموس المنجد، نجدها عبارة عن دائرة المعارف الإسلاميّة التي سنشير إليها عند دراستنا للنموذج الخامس.
ومن المصادر التي اعتمد عليها أيضاً كتاب التمدّن الإسلامي لـ(جرجي زيدان) وكتاب تاريخ الشعوب الإسلاميّة لـ(بروكلمان) الذي مُلئ بالافتراءات والتشويه للحقائق الإسلاميّة، وكمثال على ذلك ما ورد في فقرة (معركة أُحد) من إظهارٍ للرسول بمظهر المُعتدي على اليهود وأنّ القرآن الكريم قد أشاد بالخمر عطيّة
____________________
(١) وهو عبد الله كنون - بحث الموضوع في مجلّة دعوة الحقّ المغربيّة، ضمن أكثر من عشرة فصول.
(٢) وهو عبد الستّار فرّاج - في بحثٍ له في مجلّة العربي الكويتيّة.
من عطايا الله الكُبرى إضافةً إلى اختلاق عِللٍ لتشريع حرمة الخمر ما أنزل الله بها من سلطان، وغيرها من الافتراءات. ونقتطع النصّ التالي من الفقرة المذكورة نموذجاً لذلك:
( .. ولكنّها [معركة أُحد] أثّرت في مركزه [النبيّ] ومكانته عند البدو المحلّيّين. وإنّما يظهر ذلك، مثلاً، في مقتل أربعين من رُسله في ربوع قبيلة هوازن، وكان على محمّد أنْ يعوّض هذه الخسارة التي أصابت مجده العسكري من طريقٍ آخر، ففكّر في القضاء على اليهود، فهاجم بني النضير لسببٍ واهٍ وحاصرهم في حيّهم. وإذ لم يجرؤ إخوانهم في الدّين، من بني قريظة، على أنْ يسعفوهم فقد اضطرّوا إلى الاستسلام بعد حصارٍ دام بضعة أسابيع، ثمّ إنّهم هاجروا إلى واحة خيبر، التي تقع على مسافة عشرين ميلاً شمالي المدينة، والتي كانت تنزل فيها جالية كبيرة من اليهود، ووزّع النبيّ أراضي بني النضير على المهاجرين.
وعقب ذلك بقليل، حُرّمت على المسلمين الخمر، وكانت بعض الآيات (سورة ١٦: ٦٩) قد أشادت بها كعطيّة من عطايا الله الكبرى، وحُرّم الميسر، أو القمار على لحم الإبل، وكان سبباً في إفقار كثير من البدو، والواقع أنّ تحريم الخمر (سورة ٢: ٢١٦ وسورة ٥: ٩٢) كان يهدف إلى تقييد الشعراء الذين كانوا كثيراً ما يتغنّون بمجالسهم الخمريّة المعربدة، هذه المجالس الّتي كانت خليقةً بأنْ تُفسد روح النظام العسكري الصارم الّذي أراده محمّد لأتباعه، ولكن بعض المسلمين لم يلبث أن خرج على القانون، فعاقر الخمرة).
ومن نماذج الافتراءات والتزوير في قاموس المنجد - التي تكشف عباراتها وشروحها عن تعصّب وحقد وفساد في المنهج وبعدٍ كبيرٍ عن العلميّة والإنصاف - ما جاء تحت مادّة (محمّد) (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بالنص التالي:
( محمّد نبيّ المسلمين من بني هاشم، تزوّجَ مِن خديجة ورُزق منها فاطمة، دعا الأعراب إلى الإسلام وانتصر على المكّيين في بدر، ولكنّهم غلبوه في أُحد، فحاربهم في حنين ودخل مكّة ظافراً)، وهذا كلامٌ ناقصٌ مشوب بتجاوز الحقائق، حاقدٌ لا يمثّل الحقائق التاريخيّة الثابتة.
ولا نشكّ في أنّ قاموس المنجد من أخطر القواميس، التي انتشرت في دائرة واسعة وتناولته الأيدي في كلّ مكان، وذلك لما يحملهُ من أخطاء وافتراءات وتزوير حاقد، خصوصاً فيما حقّقهُ من إدخال كثير من المصطلحات الكنسيّة والطائفيّة واللاهوتيّة إلى الألفاظ العربيّة، علماً بأنّ هذه المصطلحات ليست عربيّة أصلاً، فضلاً عن تفسيرها من قبلهم تفسيراً لا يتّفق مع مفاهيم الإسلام، ونحن عندما نراجع الجانب اللّغوي والتاريخي لهذا القاموس نجده يُقحم تعابير واصطلاحات خاصّة بالكهّان النصارى كمصطلح: كهنوتي، وقدس، وقدّاس.. وغير ذلك، في المفردات اللغويّة ومعانيها.. وهكذا في الحقائق والمعارف التاريخيّة.
وتتجلّى النظرة الواقعيّة لهذا القاموس لو طالعنا المصادر التي أشرنا إليها، والّتي اعتمد عليها المؤلّف، وهي جميعها مصادر غير أصيلة؛ لأنّها تتراوح بين مصادر أجنبيّة متّهمة في دوافع مؤلّفيها، ومصادر حديثة كدائرة المعارف الإسلاميّة ومجاني الأدب للأب(شيخو اليسوعي) ومؤلّفات جرجي زيدان وبروكلمان(١) .
وقد ملأت المطاعن في نزاهة وموضوعيّة هذه المراجع وقيمتها العلميّة الآفاق، وأصبح عدم الوثوق بها أمراً قطعيّاً. كما أنّنا لا نجد بين هذهِ المصادر أيّ مرجع أصلي من الكتب العربيّة المعتمدة في كثير من المواد التي يشتمل عليها هذا القاموس، إضافة إلى أنّ الترجمة من المصادر الأجنبيّة، كثيراً ما يُغيّر فيها لفظ الشيء المترجم، خصوصاً إذا كان المترجَم له ليس عَلَماً، بل اسم محلّ أو شخص غريب، فلا ينفع في هذهِ الحالة إلاّ الرجوع للمصادر الأصلية التي تورده على وجههِ.
وقد أشار بعض الباحثين إلى أنّ من أكبر الأخطاء المتعمّدة والدسّ والتلبيس في هذا القاموس، هو سكوته عن بعض الحقائق الثابتة تاريخيّاً عند المسلمين، كموقفه من مسيلمة الكذّاب الذي ادّعى النبوّة، حيث يقول عنهُ:
____________________
(١) كنون، عبد الله - مجلّة دعوة الحق المغربيّة.
(مسيلمة من بني حنيفة من اليمامة عاصرَ محمّداً وعرض عليه أنْ يشاركهُ النبوّة، فقُتِل في موقعة عقرباء)، ولم يذكر شيئاً آخر وسكت، وهنا يُلاحظ القارئ مدى تمويههم للحقائق عن طريق التلاعب بالعبارات، إضافةً إلى أنّ عدم ذكر أكذوبة نبوّة مسيلمة ستجعل القارئ يتخيّل، أو يحتمل أنّ مسألة النبوّة كانت أمراً يُتنافس عليه أو - على الأقلّ - تصوّر إمكان صدق دعوى مسيلمة بالنبوّة في مقابل دعوى محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم).
الموسوعة الإسلاميّة الميسرة
هذه الموسوعة هي خلاصة دائرة المعارف الإسلاميّة، أُعدّت تحت إشراف اثنين من كبار المستشرقين وهما: الانجليزي(جب) (١) والهولندي(كريمرز) (٢) ، وقد كُتبت باللغة الإنجليزية، وتقع في مجلّدٍ واحد، وتُرجمت إلى اللّغة العربيّة تحت إشراف الدكتور راشد البرّاوي، وطبعتها مكتبة(الانجلو) في القاهرة وصدرت في مجلّدين بتعداد ١٢٥٦ صفحة من القطع الكبير(٣) .
وفي معرض بيان اتّجاه وطبيعة هذه الموسوعة يقول الدكتور سالم اليافعي: (إنّ الموسوعة الإسلاميّة الميسّرة هي خلاصة الفكر الغربي خلال القرون الأربعة الأخيرة، وإنّ الذين اشتركوا في إعدادها تصل قائمة أسمائهم إلى أربعمِئة اسم)، وفي مهرجان طبّي كبير في تركيا قام الدكتور اليافعي بحرق غلاف الموسوعة الإسلاميّة الميسّرة، إعلاناً منه بأنّ الأُمّة الإسلاميّة قد وصلت على حدّ تعبيره إلى مرحلة(انفصام) العقل العربي الإسلامي عن(لبان) الحضارة النصرانيّة
____________________
(١) جب، هاملتون ألكسندر روسكين Gibb, Hamilton Alexander Rosskeen ( ١٨٩٥م) مستشرق انجليزي عُني بدراسة التراث الإسلامي وتعريف الغربيين به. من أشهر آثاره: دراسات في حضارة الإسلام (عام ١٩٦٢م)، وقد نقله إلى اللغة العربيّة الدكاترة إحسان عبّاس ومحمّد يوسف نجم ومحمود زيد. (عن موسوعة المورد ج٤).
(٢) ج - هـ - كريمرز H. Kramers J .: مستشرق هولندي كثير الطعن في الإسلام، وصاحب ميول تبشيريّة سافرة.
(٣) الجندي، أنور - مؤلّفات في الميزان - مجلّة المنار: العدد ٧ السنة ١١.
اليهوديّة والعقل الاستشراقي الغربي، وهي في نفس الوقت دعوة للعودة إلى المنابع الإسلاميّة، ممثّلة في القرآن الكريم وعلومه الإنسانيّة الكبرى، وتراثنا الحضاري الشامخ من علمٍ وطبٍّ وتاريخ وفقه وسياسة واقتصاد.
ويمكننا القول: إنّ هذه الموسوعة تمثّل عصارة الجهد الاستشراقي في النيل من الإسلام، والغضّ من شأنه من خلال ما يقارب ألف كتاب اعتمدت عليها مصادر لها، كانت قد أُلّفت خلال أكثر من أربعمِئة عام.
والمثير في الأمر أنّ الانطلاقة التي بدأها المستشرقون في توجّههم هذا كان له سابقة في أوربّا، وهي ما قام به الطبيب(باراسلوس) عام ١٥٢٧م في مدينة بازل بسويسرا حيثُ أحرق كتب الطبيب المسلم ابن سينا في الميدان العام بمدينة بازل، مسجّلاً بذلك نهاية تبعيّة أوربّا للحضارة الإسلاميّة، وبداية الهيمنة الثقافيّة والحضاريّة لأوربّا على الشرق الإسلامي.
أمّا مفردات الدسّ والتشويه التي حوتها هذه الموسوعة فلا تنحصر بزاوية واحدة، بل إنّها ضمن مناقشتها للقضايا الأساسيّة تشمل الجوانب المتّصلة بالعقيدة، كالرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) والقرآن الكريم والسنّة الشريفة، وكذلك ما هو متّصل بأركان وفروع التشريع الإسلامي، كالصلاة والحجّ وغيرها، هذا إضافة إلى تناولها لجوانب من التاريخ الإسلامي وسيرة كبار رجال الإسلام وقادته. وبملاحظة نقديّة أوليّة نستجلي ما دُفن فيها من تحريف وتشويه، وتزكم أنوفنا رائحة السموم التي دُسّت في موادّها بأيدي مستشرقين يهود ونصارى بهدف تشويه معالم الفكر الإسلامي الأصيل وإثارة الشبهات حول تاريخه الناصع وشخصياته القياديّة.. ويمكننا سوق نماذج عن ذلك كالآتي:
١ - في جانب السيرة النبويّة وتحت مادّة (محمّد) (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، ومادّة (قرآن) نجدهما مليئتين بالدسّ اليهودي والتحريف النصراني، والشبهات المفتعلة حول أحداث السيرة الشريفة وحقيقة القرآن الكريم، كما نجدهما قد كُتبتا بطريقةٍ نكراء
تُثير الاستغراب وتفتقر إلى المنهج العلمي السليم والأمانة التاريخيّة المطلوبة، ويزول منّا هذا الاستغراب إذا عرفنا أنّ كاتبهما هو المستشرق الشهير(بوهل) ، الذي امتلأت مؤلّفاته بإثارة الشبهات والدسّ والتشويه، والذي يُعدّ من أكثر المستشرقين حِقداً على الإسلام وعلى نبيّه الكريم محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم).
ففي مادّة (سيرة) مثلاً عند بيان أصل السيرة وطبيعتها يدرك القارئ لها مدى الغمز - وفي مواضع متعدّدة - بأخلاق الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وما عُرِف عنه مِن أمانةٍ وصدق، سواءٌ في سلوكه الخاص أم في دعوته لرسالته، كما في المقاطع التالية من هذه المادّة:
( إنّ فكرة جمع قصّة حياة النبيّ من مولده إلى وفاته في رواية متتابعة محكمة، ليست فكرة قديمة في الجماعة الإسلاميّة، ولا هي بالفكرة التي جاءت عفو الخاطر... هذا الاهتمام أبعد ما يكون عن طبيعة التاريخ بالمعنى الذي نفهمه من هذه الكلمة، وإنّما انصرف إلى تخليد ذكر المغازي على غرار ما كان يفعل العرب في الجاهليّة، تلك المغازي التي اشترك فيها المسلمون، تحت راية قائدهم الذي كان جلّ أتباعه ينظرون إليه نظرتهم إلى أمير...
وإنْ كان [النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم)] لا يختلف في خُلِقه اختلافاً مشهوداً عن أُمراء الجاهليّة، وقد كان الحافز الأوّل إلى هذا الاهتمام هو الذي دفع القوم، كما نعلم، إلى إقامة السُنّة في تلك الصورة المأثورة من الحديث المروي...
فليست هذه المغازي إلاّ استمراراً أو تطوّراً لأيّام العرب... هذه السيرة يرجع أصلها إلى التحوّل الذي طرأ على شخصيّة محمّد في ضمير المسلمين الديني، وإلى شيءٍ آخر فوق هذا كلّه، وهو أنّ احتكاك المسلمين باليهوديّة والمسيحيّة، ورغبتهم في أنْ يضعوا مُنشئ الإسلام في كفّة مُنشئي هذين الدّينين، قد شجّعاهم على وضع تلك القصص التي أحاطوا بها شخص النبيّ، والتي أحدثت هذا التحوّل الشامل في طبيعة شخصيّته من مولده (بل قبل مولده) إلى وفاته).
٢ - في جانب التاريخ الإسلامي وسيرة الشخصيّات البارزة فيه قُلِبت الكثير من الحقائق، ودُسّت الكثير من السموم والشبهات، حتّى لكأنّك تقرأ
تاريخاً وسيرةً أُخرى لا تمتّ للإسلام والمسلمين بصلة.
ومن الشخصيّات التي طالتها الشبهات ودُسّت في سيرتها السموم، بعض صحابة الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كحمزة بن عبد المطّلب، والعبّاس بن عبد المطّلب، وبلال الحبشي، ومُصعب بن عُمير، وكذلك بعض أُمّهات المؤمنين، بل طالت أيضاً بعض الأنبياء السابقين، الّذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم: كنبيّ الله صالح (عليه السلام)، ونبيّ الله شعيب (عليه السلام).
فمثلاً من صور التشويه لسيرة حمزة بن عبد المطّلب عمّ النبيّ، والحطّ من شخصيّته ومصداقيّة انتمائه المبدئي للإسلام ما يقوله المستشرق(لامنس) في مادّة (حمزة) من أنّه:
( عمّ النبيّ، وتزيد الروايات أنّه أخوه في الرضاعة سعياً منها إلى تمجيد هذا البطل من أبطال الإسلام في عهده الأوّل، ولا نعرف عن حمزة فيما عدا ذلك إلاّ القليل، ويزعم الجهّال من مادحيه أيضاً أنّه اشترك في حرب الفجار...
وفي أوّل الأمر وقف حمزة من الدّين الجديد موقف العِداء، شأنه في ذلك شأن سائر بني هاشم، على أنّ لجاج أبي جهل في خصومة النبيّ استثاره، ومِن ثمّ يُقال إنّه دخل في الإسلام بعد نزول الوحي على محمّد بسنتين، أو بستّ في روايات أُخرى.
ثمّ هاجر معه إلى المدينة وعاش فيها أوّل الأمر عيشة المغمور البائس، حتّى لقد بلغ من أمره أنْ خرج عن وعيه في يوم من الأيّام، تحت تأثير الإفراط من الشراب وحمل بسيفه على جِمالٍ لعليّ) .
٣ - في جانب آخر من التاريخ الإسلامي، أبرزت الموسوعة اهتماماً كبيراً بأصنام العرب قبل الإسلام، وما أسمته بطقوس الحجّ، التي حاولت أنْ تخلط فيها بين طقوس الحجّ قبل الإسلام وما شرّعه الإسلام من فرائض عبادة الحجّ.
هذه إلمامة إجماليّة سريعة عن مفردات الدسّ والتشويه الذي تضمّنته هذه الموسوعة، ومن المؤسف أنْ نجد أنّ الأهداف الخبيثة التي استهدفتها هذه الموسوعة وأمثالها، قد أثمرت من خلال انخداع الكثير من أبناء الإسلام بها، خصوصاً أبناء الجيل الحديث مِن مثقّفي وخرّيجي المدارس والجامعات العربيّة، حيث جعلوه
مصدر إلهامهم الرئيسي لمعرفة دينهم وحضارتهم وتاريخهم الإسلامي.
ونتيجة للخطر الذي استشعره بعض الكتّاب والمتتبّعين لخطط المستشرقين، في تشويه معالم الدين الإسلامي وتاريخه وحضارته، من خلال هذه الموسوعات عمدوا إلى تقديم البديل عنها، وتوجيه أبناء الإسلام لاستقاء معارف دينهم وتاريخهم وحضارتهم منها، ومن هؤلاء الكتّاب الأستاذ أحمد عطيّة الله الذي قام بتأليف(القاموس الإسلامي) بديلاً عن الموسوعة الإسلاميّة الميسّرة، الذي حرص فيه على تصحيح جميع ما فيها من أخطاء، إلاّ أنّه توفّي قبل أنْ يتمّه.
كما قامت جامعة البنجاب في الهند بمحاولةٍ أُخرى في مجال تقديم البديل، فعمدت إلى رفع جميع الموادّ المحرّفة والمشبوهة، التي وردت في دائرة المعارف الإسلاميّة وخلاصتها، المتمثّلة بالموسوعة الإسلاميّة الميسّرة، وقدّمت البديل الإسلامي عنها بأقلام علماء مسلمين، ثمّ ترجمت هذه الدائرة بشكلها المصحّح إلى لغة الأُردو.
وقامت مؤسّسة مكتب التربية العربي لدول الخليج بإصدار كتاب في مجلّدين، ضمّ أكثر من ٣٠ بحثاً بالردّ على بعض الكتب الاستشراقيّة المشهورة، الطافحة بالتشويه والمليئة بالدسّ والسموم.
ولعلّ معالم الصحوة والوعي الإسلامي، الذي برز في أُفق الأمّة الإسلاميّة، والمدد الإلهي الذي يشعّ من مراكزها العلميّة الرائدة، هيّأت أرضيّةً خصبةً، وخلقت توجّهاً كبيراً لمحاكمة كلّ ما كتبه الغرب عن الإسلام والمسلمين، سواءٌ كان بأقلام المستشرقين والمبشّرين أنفسهم أم بأقلام خرّيجي مدارسهم من أبناء الشرق، وبدأت هذه المحاكمة على شكل أبحاث شاملة ودراسات موسوعيّة، بأُسلوبٍِ علميٍّ ومنهجٍ هادف على شكل كتب أخذت مكانتها في المكتبة الإسلاميّة، أو على صفحات المجلاّت المتداولة، ممّا يجعلنا نطمئنّ إلى أنّ ما حاكه الاستكبار الغربي على يد مَن يُسمّيهم بالمستشرقين، قد بدأ عدّه التنازلي وأُفوله في عالم العلم والمعرفة.
دائرة المعارف الإسلاميّة
لقد كُتبت دائرة المعارف الإسلاميّة - وهي أوسع إنتاج موسوعي استشراقي - من قبل مجموعة كبيرة من المستشرقين من جنسيّات أوربيّة مختلفة، وكان المشرف على معظم موادّها هو المستشرق(فنسنك) أو (ونسنك)(١) المعروف بأنّهُ مِن أكبر المتعصّبين ضدّ الإسلام، والذي يدّعي أنّ الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ألّف القرآن من خلاصة الكتب الدينيّة والفلسفيّة التي سبقته(٢) ، وقد نشرت هذه الدائرة باللغة العربيّة مرّتين، الأولى عام ١٩٣م إلى حدّ الحرف (عليه السلام)، والمرّة الثانية في السبعينات دون أيّ تغيير في موادّها.
ولغرض الإحاطة العلميّة بأهمّ جوانب التشويه والدسّ الذي اشتملت عليه هذه الدائرة، والأغراض والأهداف الكامنة خلف ذلك، لا بدّ لنا أنْ نتناولها من جانبين رئيسيّين:
الجانب الأوّل: وهو التعرّف على هويّة وخلفيّة أبرز العقول والأقلام التي تصدّت لكتابتها، والهدف من ذلك هو تسليط الضوء على منهج تفكير محرّري هذه الدائرة، ومدى قربهم وبعدهم عن الموضوعيّة والأمانة العلميّة في النقل والتدوين والاستنتاج، واكتشاف الأغراض والأهداف غير العلميّة - إنْ
____________________
(١) راجع الترجمة الخاصّة بـ (فنسنك) في الفصل الخامس: (نماذج من كبار المستشرقين في منهج تناولهم للشرق الإسلامي).
(٢) د. الهواري، حسين (المستشرقون والإسلام) ص٧١٠ وما بعدها.
وُجِدت - التي تكمن وراء ما يقع بين أيدينا من صُور ومفردات التشويه والدسّ، التي تظهر لنا أثناء التتبّع والملاحظة العلميّة النقديّة لموادّ وفصول هذه الدائرة.
الجانب الثاني: وهو مادّة الدائرة ومطالبها العلميّة، ويتمّ ذلك من خلال التتبّع التفصيلي بروح علميّة منطقيّة لموادّ وفصول هذه الدائرة، واكتشاف موارد الدسّ والتشويه فيها بعيداً عن التحميل والاختلاق، وتسليط الضوء على طبيعتها ودرجة أهمّيّتها، لتكون عاملاً مساعداً في نجاح محاولتنا لاكتشاف أهداف وأغراض هذا التشويه والدسّ.
هويّة وخلفيّة أبرز كتّابها
وفي هذا الجانب نُورد ترجمة مختصرة لنماذج من المستشرقين الذين شاركوا(فنسنك) في تحرير دائرة المعارف هذهِ وهُم:
١ - لويس ماسينيون ( Louis Massignon ١٢٩٩ - ١٣٨٢هـ، ١٨٨٣ - ١٩٦٢م)(١) :
أكبر مستشرقي فرنسا المتأخرين، وصفهُ الدكتور محمّد البهي في كتابه(الفكر الإسلامي الحديث وصلتُه بالاستعمار الغربي) بأنّه من المستشرقين الخطرين. عمَل موظّفاً في وزارة المستعمرات الفرنسيّة في شبابه، ثمّ مستشاراً لها بقيّة حياته، الراعي الروحي للجمعيّات التبشيريّة الفرنسيّة في مصر. زار العالم الإسلامي أكثر من مرّة، وخدم بالجيش الفرنسي خمس سنوات في الحرب العالميّة الأولى. كانَ عضواً بالمجمع اللغوي المصري والمجمع العربي العلمي في دمشق. متخصّص في الفلسفة والتصوّف الإسلامي(٢) .
____________________
(١) لمزيد من التفصيل لغرض الإحاطة بهويّة وتوجّهات هذا المستشرق، راجع ترجمته الخاصّة في الفصل الخامس: (نماذج من كبار المستشرقين في منهج تناولهم للشرق الإسلامي).
(٢) الزركلي، خير الدين - الأعلام (قاموس تراجم) م٥ وكذلك الدكتور البهي، محمّد - الفكر الإسلامي = الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ص٥٥٦.
٢ - يوسف شخت ( Joseph Schakhet ١٣٢٠ - ١٣٩٠هـ، ١٩٠٢ - ١٩٧٠م):
مستشرق هولندي من أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق، ولد في مدينة راتييور بألمانيا، درس اللغات الشرقيّة وتخصّص بالعربيّة، ونال الدكتوراه في الفلسفة عام (١٩٢٣م)، ودرّس اللغات الشرقيّة بجامعة فراييورغ (١٩٢٧م)، وانتقل إلى جامعة كونكسيرج (١٩٣٢م)، وفي عام (١٩٣٤م) عُين أُستاذاً لتدريس اللغات الشرقيّة في الجامعة المصريّة، وعمل في وزارة الاستعلامات البريطانيّة (١٩٣٩ - ١٩٤٥م)، وتجنّس بالجنسيّة البريطانيّة، ودرّس في جامعة أكسفورد، وجامعة الجزائر، فجامعة ليدن بـ(هولندا) عام (١٩٥٤ - ١٩٥٩م)، ثمّ في جامعة كولومبيا بـ(نيويورك)، عُرفَ بتعصّبه ضدّ الإسلام والمسلمين.
من أعمالِه تصحيح كتب للخصاف ولمحمّد بن الحسن الشيباني وللقزويني، وجزأين من (الشروط) الكبير للطحاوي، وكتاب جالينوس في(الأسماء الطبيّة) من ترجمة حنين، وكتب أُخرى في الفقه والفلسفة والطب، ولهُ مؤلّفات باللغات الألمانيّة والانجليزيّة والفرنسيّة في (تاريخ الأدب العربي) و(الفقه الإسلامي)، وله في مجلّة المشرق ثلاث محاضرات بالعربيّة في (تاريخ الفقه الإسلامي)(١) .
٣ - هنري لامنس اليسوعي ( H. Lommens ١٢٧٨ - ١٣٥٦هـ، ١٨٦٢ - ١٩٣٧م):
مستشرق بلجيكي المولد، فرنسي الجنسيّة، من علماء الرهبان اليسوعيّين، تعلّم في(لوفان) وفي(فيَنّا) ، وتلقى علم اللاهوت في انجلترا، وكانَ أستاذاً للأسفار القديمة في كلّية (روما)، استقرّ في (بيروت) فتولّى إدارة جريدة
____________________
(١) مجلّة مجمع اللغة العربيّة بدمشق ٤٦: ٢٠٢، والرسالة ٢: ١٧١٥، والمشرق ٢٨ و٢٩ و٣٢ و٣٣، والمستشرقون ٨٠٣، ومجلّة الدراسات الإسلاميّة بمدريد ١٣: ٢٢١. عن الزركلي، خير الدين - الأعلام (قاموس تراجم) م٨ وعن د. البهي، محمّد - الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ص٥٥٨.
(البشير) مدّة من الزمن، وكذلك إدارة مجلّة (المشرق)، ودرس في الكلية اليسوعيّة، شديد التعصّب ضدّ الإسلام والحقد عليه، مفرط في عدائه وافتراءاتهِ لدرجة أقلقت بعض المستشرقين أنفسهم. (انظر ص١٥ - ١٦ من العدد ١، من المجلّد ٩ يناير سنة ١٩٢٥م من (مجلّة جمعيّة الدراسات الشرقيّة الأميركية)، اشتهر بأبحاثه عن عرب الجاهليّة والعهد الأموي، وصنّف كتباً عن العرب والإسلام بالفرنسيّة، وكتباً بالعربيّة، منها:
(مهد الإسلام)، (مكّة قُبيل الهجرة)، (الطائف قُبيل الهجرة)، (الجزيرة العربيّة الغربيّة قُبيل الهجرة)، (الإسلام)، (خلافة معاوية)، (خلافة يزيد)، (تاريخ سوريا)، (فرائد اللغة)، (المذكرات الجغرافيّة في الأقطار السوريّة)، (تسريح الأبصار فيما يحتوي لبنان من الآثار) جزءان، (الألفاظ الفرنسيّة المشتقّة من العربيّة)، (مختارات للترجمة من العربيّة إلى الفرنسيّة وبالعكس)، مات في بيروت(١) .
٤ - رينولد ألين نيكلسن ( Reynold Allen Nicholson ١٢٨٥ - ١٣٦٤هـ، ١٨٦٨ - ١٩٤٥م):
من أكبر مستشرقي انجلترا المتأخّرين، تخصّص في التصوّف الإسلامي والفلسفة، تعلّم في كمبردج وغيرها، ودرس العربيّة والفارسيّة ودرّسهما في جامعة كمبردج، كان عضواً بالمجمع اللغوي المصري، وهو من المنكرين على الإسلام أنّهُ دين روحي، ويصفهُ بالماديّة وعدم السموّ الإنساني، اشترك في نشر (تذكرة الأولياء) للعطّار، و(اللمع) للسرّاج، و(ترجمان الأشواق) مقالات في التصوّف لابن عربي، ولهُ كتب بالانجليزيّة منها: (تاريخ الآداب العربيّة) صدر سنة ١٩٣٠م، و(متصوّفو الإسلام) صدر سنة ١٩١٠م،
____________________
(١) مجلّة المشرق ٣٥: ١٦١، والمستشرقون ٦٧، ومعجم المطبوعات ١٥٨٥، والربع الأوّل من القرن العشرين، ١٥٩ والكتبخانه ٤: ١٧٦. عن الزركلي، خير الدين - الأعلام (قاموس تراجم) م ٨، وعن د. البهي، محمّد - الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ص٥٥٨. وعن المنجد (الأعلام) ص٦٠٩.
و(دراسات في التصوّف الإسلامي) ترجمهُ إلى العربيّة أبو العلا عفيفي ونشر بها، و(ترجمات من الشعر والنثر) عن العربيّة والفارسيّة، وتَرجم وحلّل كتاب (المثنوي والمعنوي) لجلال الدين الرومي(١) .
٥ - دافيد صموئيل مرجليوث ( Davide Samuel Margoliouth ١٢٧٤ - ١٣٥٩هـ، ١٨٥٨ - ١٩٤٠م):
وهو ابن حزقيال الانجليزي البروتستانتي، متعصّب ضدّ الإسلام، ومن كبار المستشرقين، من أعضاء المجمع العلمي العربي بـ (دمشق). كان عضواً بالمجمع اللغوي المصري، والمجمع اللوي البريطاني، وجمعية المستشرقين الالمانية. مولده ووفاته بـ (لندن). تعلّم في جامعة أكسفورد، وعين أُستاذاً للعربيّة فيها سنة ١٨٩٩م، وعمل في مجلّة الجمعيّة الآسيويّة الانجليزيّة، ترأس تحريرها، ونشر فيها بحوثاً، منها (فهارس) لديوان أبي تمّام، وزار الشرق الأوسط مراراً.
وممّا يذكر أنّه صحب الكولونيل(بلفور) في زيارة لـ(بغداد) لمساعدة القيادة العسكريّة البريطانيّة العامّة في بعض الأمور(٢) .
وفي إحدى الاجتماعات التي افتتحها بلفور قدّم للحاضرين (مرجليوث)، وقام هذا المستشرق فأخذ يخطب باللغة العربيّة، ومن جملة ما قاله لهم: (إنّ العراق قد تعوّد على حكم الأجانب منذُ القديم، فقد حكمه المغول، وحكمه الأتراك، وحكمه الإيرانيّون، وهو لا يستطيع أنْ يحكم نفسه، وعلى هذا يجب على العراقيّين أنْ يختاروا الانجليز أوصياء عليهم، أو تحت انتدابهم أو حمايتهم)(٣) .
من مؤلّفاته بالعربيّة كتاب (آثار عربيّة شعريّة)، وامتاز بكثرة ما نشره من
____________________
(١) المستشرقون ٩٤، ومجلّة الكتاب ١: ١٢١، ومعجم المطبوعات ١٨٨٦م. عن الزركلي، خير الدين - الأعلام (قاموس تراجم) م٣. وعن د. البهي، محمّد - الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ص٥٥٧، وعن المنجد (الأعلام) ص٧٢١. وعن البعلبكي، منير - موسوعة المورد - المجلّد السابع ص١٢٩.
(٢) Burgoyne (Gertude Boll) London ١٩٦١ – vol ٢ p ١٠٣.
(٣) البازركان، عليّ (الوقائع الحقيقيّة) ص٦٧.
مؤلّفات العرب، (كمعجم ياقوت) و(إرشاد الأريب) و(الأنساب)، للسمعاني، و(ديوان ابن التعاويذي) و(حماسة البحتري) و(نشوار المحاضرة) للتنّوخي و(رسائل أبي العلاء المعرّي) مع ترجمتها إلى الانجليزيّة.
وله في لغته كتب عن الإسلام والمسلمين، لم يكن فيها مخلصاً للعلم على الرغم من توسّعه في معرفة المسلمين وأدبهم، منها (نشأة الإسلام الأُولى) صدر في سنة ١٩١٣م، و(محمّد وظهور الإسلام) صدر في سنة ١٩٠٥م، و(الجامعة الإسلاميّة) صدر في سنة ١٩١٢م(١) .
٦ - دانكن بلاك ماكدانلد ( Duncan Black Macdonald ١٣٦٢هـ،..... ١٩٤٣م):
مستشرق أميركي من أشدّ المتعصّبين ضدّ الإسلام، يصدّر في كتاباته عن روح تبشيريّة متأصّلة، من أوسع المستشرقين اطّلاعاً على الدين الإسلامي، ومن كبار محرّري (دائرة المعارف الإسلاميّة)، ومن كتبه: (تطور علم الكلام والفقه والنظريّة الدستورية في الإسلام) صدر سنة ١٩٠٨م.
تعلّم العربيّة والعبريّة والسريانيّة، وله محاضرات ومقالات كثيرة بالانجليزيّة عن الثقافة الإسلاميّة في أكثر نواحيها، ونشر بالانجليزيّة (فهرس المخطوطات العربيّة والتركيّة في مكتبة نيوبري بشيكاغو)، وعني بكتاب (ألف ليلة وليلة) فجمع منه نسخاً لا توجد عند غيره(٢) .
٧ - أجناس كولد صيهر( Ignaz Gold ziher ١٢٦٦ - ١٣٤٠هـ، ١٨٥٠ -
____________________
(١) المشرق ٣٩: ٥٤ - ٥٧ وسركيس ١٧٢٨ والمستشرقون ٩٣ وجريدة الأهرام ٤/٣/١٩٤٠م. عن الزركلي، خير الدين - الأعلام (قاموس تراجم) م٢. وعن د. البهي، محمّد - الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي - ص٥٥٧. وعن البعلبكي، منير - موسوعة المورد - المجلّد السادس ص١٩٦.
(٢) مجلّة المجمع العلمي ٩: ٩٥ و٤٧١، ودليل الأعارب ١٤٥. عن الزركلي، خير الدين - الأعلام (قاموس تراجم) م٢. وعن د. البهي، محمّد - الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي - ص٥٥٦.
١٩٢١م):
مستشرق مَجَري موسوعي، عرف بعدائهِ للإسلام وبخطورة كتاباته عنه، تعلّم في (بودابست وبرلين وليبسيك)، ورحل إلى سوريا سنة ١٨٧٣م، وانتقل إلى فلسطين، فمصر. وعيّن أستاذاً في جامعة (بودابست) (عاصمة المجر) وتوفّي بها.
له تصانيف باللغات الألمانيّة والإنجليزيّة والفرنسيّة في الإسلام والفقه الإسلامي والأدب العربي، ترجم بعضها إلى العربيّة، ونشرت مدرسة اللغات الشرقيّة بـ (باريس) كتاباً بالفرنسيّة في مؤلّفاته وآثاره، وممّا نشره بالعربيّة (ديوان الحُطيئة)، وجزء كبير من كتاب (فضائح الباطنيّة) المعروف بالمستظهري للغزالي، وترجم إلى الألمانيّة كتاب (توجيه النظر إلى علم الأثر) لظاهر الجزائري، وكتاب (المعمّرين) للسجستاني، وغيرهما، وترجم إلى العربيّة من كتبه (العقيدة والشريعة في الإسلام)، كتب عن القرآن والحديث، ومن كتبه في ذلك (تاريخ مذاهب التفسير الإسلامي) المترجَم إلى العربيّة تحت نفس العنوان(١) .
٨ - أ. ج. أربري A. J. Arburry :
مستشرق انجليزي معروف بالتعصّب ضدّ الإسلام والمسلمين. عمل أستاذا بجامعة كمبردج. ومن المؤسف أنّه أُستاذ لكثير من المصريّين، الذين تخرّجوا في الدراسات الإسلاميّة واللغويّة في انجلترا.
ومن كتبه: (الإسلام اليوم) صدر عام ١٩٤٣م، و(مقدّمة لتاريخ التصوّف) صدر عام ١٩٤٧م، و(التصوّف) صدر عام ١٩٥٠م و(ترجمة القرآن) صدر عام ١٩٥٠م(٢) .
____________________
(١) مجلّة المجمع العلمي العربي ١: ٣٨٧ ثمّ ١٠: ١٨٨، والتراث اليوناني لعبد الرحمان بدَوي ٣٠٧، والعقيدة والشريعة في الإسلام: مقدّمته، والربع الأوّل من القرن العشرين ١٣١، والمستشرقون ١٩٦، وفي مجلّة الزهراء ١: ٣٢١ رسالته منه إلى الشيخ طاهر الجزائري، بالعربيّة بخطّه، كتب توقيعه عليها: (العبد الحقير الفقير إجناس كولد صيهر المجَري). وعن الزركلي، خير الدين - الأعلام (قاموس تراجم) م١. وعن د. البهي، محمّد - الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ص٥٥٣.
(٢) د. البهي، محمّد - الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي - ص٥٥٢.
٩ - كارل بروكلمان ( Carl pockelmann ١٢٨٥ - ١٣٧٥هـ، ١٨٦٨ - ١٩٥٦م):
مستشرق ألماني يُعتبر أحد أبرز المستشرقين في العصر الحديث، عالم بتاريخ الأدب العربي. ولِد في(رستوك) بـ (ألمانيا) ونال شهادة (الدكتوراه) في الفلسفة واللاهوت، وأخذ العربيّة واللغات السامية عن(نولدكه) وآخرين. درّس في عدّة جامعات ألمانيّة، وكانت ذاكرته قويّة يكاد يحفظ كلّ ما يقرأ. ودرّس العربيّة في معهد اللغات الشرقيّة بـ (برلين) عام ١٩٠٠م، وتنقل في التدريس، وتقاعد سنة ١٩٣٥م.
عمل في الجامعة متعاقداً سنة ١٩٣٧م، ثمّ كان سنة ١٩٤٥م أميناً لمكتبة الجمعيّة الألمانيّة للمستشرقين، وأمضى أعوامهُ الأخيرة في مدينة(هالة) ، وكان من أعضاء المجمع العلمي العربي في دمشق، وكثير من المجامع والجمعيّات العلميّة في ألمانيا وغيرها.
صنف بالألمانيّة (تاريخ الأدب العربي) في مجلّدين، وأتبعهما بملحق في ثلاثة مجلّدات، وكلّفته جامعة الدول العربيّة أنْ يُدخل الملحق في الأصل، وينقلها إلى العربيّة، ولبروكلمان (تاريخ الشعوب الإسلاميّة) ترجم إلى العربيّة في بيروت وطبع بها في خمسة أجزاء صغيرة، وفهرسان لخزانتي برسلاو وهامبورغ، يُعرِّفان بمخطوطاتهما العربيّة، وكتاب في (نحو اللغة العربيّة) بالألمانيّة، و(معجم للغة السريانيّة) و(قواعد السريانيّة)، و(ترجمة ديوان لغات الترك) للكاشغري، إلى الألمانيّة، وكلّها مطبوعة.
وممّا نشر بالعربيّة قسمٌ كبيرٌ من (عيون الأخبار) لابن قتيبة، ورسالة (تلقيح مفهوم أهل الآثار) لابن الجوزي، وجزء من (طبقات ابن سعد)، ورسالة (ما تلحن فيه العوام) للكسائي، وقد أشارت لبعض أخطائه التاريخيّة والعلميّة مجلّة (الإسلام) AL – ISLAM التي تصدر بالإنجليزيّة في (كراتشي٩ باكستان ص١٤١ من العدد الأوّل - مايو - سنة ١٩٥٨م(١) .
____________________
(١) مجلّة المجمع العلمي العربي ٣١: ٥٠٥ - ٥٠٨، وإبراهيم مدكور، في مجمع اللغة ٢٤: ١٢ - ١٦، = ومجلّة (فكر وفن) العربيّة الألمانيّة العدد ١٥، ومعجم المطبوعات ٥٥٣، والمستشرقون ١٢١، ومقال في مجلّة (الأبحاث والتطورات) الألمانيّة (آب ١٩٥٦م) بقلم المستشرق (يوهن فيك) أُمليت خلاصته من قبل المستشرق الدكتور (مُنزل) (كمرسَل) في السفارة الألمانيّة بالقاهرة.
و(قافلة الزيت) محرّم ١٣٨١هـ بقلم المستشرق (ارنست بانرت) جاء فيه: إنّ عصر الاستشراق الذهبي قد انتهى مع بروكلمان في أوربّا عامّة وفي ألمانيا خاصّة. عن الزركلي، خير الدين - الأعلام (قاموس تراجم) م٥، والدكتور البهي، محمّد - الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ص٥٤٧، والبلعلبكي، منير، موسوعة المورد - المجلّد الثاني ص١٢٠.
١٠ - كرستيان سنوك هرخرونيه ( Christian Snouck Hurgronje ١٢٧٣ - ١٣٥٥هـ، ١٨٥٧ - ١٩٣٦م):
مستشرق هولندي، ولد في (استرهوت)، وتعلم بـ (ليدن) و(ستراسبورج)، وأقام في (جدّة) بالحجاز سنة (١٨٨٤م) سبعة أشهر، يقول: إنّه دخل (مكّة) متسمّياً باسم عبد الغفّار، ومكث بها في (سوق الليل) خمسة أشهر، واضطرّ إلى مغادرتها فجأة قبل حلول موسم الحج، لانكشاف أمرهِ لكلمات فاه بها وكيل قنصل فرنسا بـ (جدة) في بعض المجالس.
رحل إلى بلاد (الجاوي) فأقام ١٧ سنة، وعُيّن أُستاذاً للعربيّة في (جامعة ليدن) سنة ١٩٠٦م، ثمّ كان مستشاراً في الأمور الإسلاميّة والعربيّة بوزارة المستعمرات الهولنديّة، له عدّة كتب بالألمانيّة عن الإسلام والمسلمين حاربهما بها، أشهرها كتابه (مكّة في القرن التاسع عشر) في مجلّدين، نشره سنة ١٨٨٩م، ومجموعة في ستّة مجلّدات، طبعها سنة (١٩٢٣ - ١٩٢٧م) في (الإسلام وتاريخه) و(الشريعة الإسلاميّة) و(بلاد العرب وتركيا) و(الإسلام في المهاجر الهولنديّة) و(اللغة والأدب) و(ملاحظات في الكتب)، ذكر فيه بعض المخطوطات وتواريخ كتابتها، و(فهارس الأجزاء المتقدّمة)(١) .
____________________
(١) أحمد عليّ، في مجلّة (الحجّ) ٥: ٣٩ من فصل مترجم عن مجلّة Islamic Review الانجليزيّة. وشكيب أرسلان في مجلّة الفتح ٢٩ شوّال ١٣٤٩هـ وهو يذكر انهُ (أسلم٩ خلال إقامته باندونيسيا، وحجّ. وحاضر العالم الإسلامي، طبعة الحلبي ١: ٣٣٨ - ٣٤٥ والمستشرقون ١٤٧، ومعجم المطبوعات ١٠٥٩ والرسالة ٤: ١١٥٩. عن الزركلي، خير الدين - الإعلام (قاموس تراجم). م٥. وعن د. البهي، محمّد - الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي - ص٥٤٥.
١١ - جودفروا ديمومبين ( Gaudefroy Demombynes ١٢٧٨ - ١٣٧٦هـ، ١٨٦٢ - ١٩٥٧م):
مستشرق فرنسي، كان أُستاذ العربيّة في مدرسة اللغات الشرقيّة بـ (باريس). صنّف كتباً عن العرب وبلادهم وأدبهم بالفرنسيّة، وترجم إليها (رحلة ابن جُبير)، وألّف متعاوناً مع(بلاشير) (قواعد العربيّة الفصحى). لهُ كتاب عن (الحجّ) فيه كثير من الخلط والتشويه. (انظر ص١٣ من العدد ١ من المجلّد ٩، يناير سنة ١٩٢٥م من مجلّة جمعيّة الدراسات الشرقيّة)(١) .
١٢ - توماس وُوكر آرنلد ( Thomas Walker Arnold ١٢٨٠ - ١٣٤٩هـ، ١٨٦٤ - ١٩٣٠م):
مستشرق إنجليزي من أهل (لندن)، تعلّم في (كمبردج) وعُيّن مدرّساً في كليّة (عليكره) بالهند سنة ١٨٨٨م، فأُستاذا للفلسفة في (لاهور)، فرئيساً للكليّة الشرقيّة في جامعة البنجاب، وعاد إلى (لندن) فعُيّن أُستاذاً للعربيّة في جامعتها سنة ١٩٠٤م، فمديراً لمعهد الدراسات الشرقيّة، وزار مصر قبيل وفاته، له كتب (تعاليم الإسلام) و(المعتزلة) و(الخلافة) بالانجليزيّة وقد ترجم الأخير إلى العربيّة وطبع.
ولهُ كتب بالانجليزيّة أيضاً في الفن والرسم الإسلاميّين، ساعده فيها (لوي بنيون) من رسّامي الفنون الشرقيّة، وقد قال في شأنهِ المستشرق (اربري): كان آرنُلد مرجعاً في الشؤون الإسلاميّة(٢) .
١٣ - رينيه باسيه ( Ren,e Basset: ١٢٧١ - ١٣٤٢هـ، ١٨٥٥ - ١٩٢٤م):
مستشرق فرنسي، من أعضاء المجمع العربي، ولد في لونيفيل وتعلّم في ناتسي، ثمّ في مدرسة اللغات الشرقيّة بـ (باريس)، وعُيّن مدرّساً للعربيّة في مدرسة
____________________
(١) د. الهي، محمّد - الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي - ص٥٤٣ وكذلك الزركلي، خير الدين - الأعلام (قاموس تراجم) م٢.
(٢) ١٧ Buckland والمستشرقين ٩٣ والمجمع العلمي العربي ٢٣، ٢٧٧ و pitish Orientalists ولوسيان بوفا في T – ٢٢٧ p – ١٤٦ Journal Asiatique عن الزركلي، خير الدين - الأعلام (قاموس تراجم) م٢.
الجزائر العليا سنة ١٨٨٢م، ثمّ تولّى إدارتها. واختير (عضواً) في كثير من المجامع العلميّة، ترأّس مؤتمر المستشرقيّن بالجزائر سنة ١٩١٠م.
نشر بالعربيّة(تحفة الزمان) لعرب فقيه، في فتوح الحبشة، مع ترجمة فرنسيّة، و(الخزرجيّة) في العروض، و(تاريخ بلاد ندرومة وترارة بعد خروج الموحّدين منها)، وله بالفرنسيّة مقالات في المجلاّت الشرقيّة في فرنسا والجزائر وتونس، وله تصانيف أيضاً، توفّي بالجزائر، ألّف في تاريخ البربر والأحباش والآداب العربيّة(١) .
١٤ - إيفارست ليفي بروفنسال ( L,evi – Provencal Evariste ١٣١١ - ١٣٧٦هـ، ١٨٩٤ - ١٩٥٥م):
مستعرب فرنسي الأصل، كثير الاشتغال بتصحيح المخطوطات العربيّة ونشرها، ولِد وتعلّم في الجزائر، وحضر حرب الدردنيل في الجيش الفرنسي، فجرح ونُقل إلى مصر ثم أُعيد إلى فرنسا.
عُيّن سنة ١٩٢٠م مدرّساً في معهد العلوم العليا المغربيّة في الرباط، فمديراً له (سنة ١٩٢٦ - ١٩٣٥م) وانتدب من خلال ذلك سنة (١٩٢٨م) لتدريس تاريخ العرب والحضارة الإسلاميّة في كليّة الآداب بالجزائر، كما انتُدبَ لتدريس تاريخ العرب وكتاباتهم بمعهد الدراسات الإسلاميّة في السوربون بـ (باريس)، واستقال من إدارة معهد الرباط (سنة ١٩٣٥م)، ودُعي لإلقاء محاضرات في جامعة القاهرة (سنة ١٩٣٨م)، وألحقهُ وزير التربيّة الفرنسيّة بديوانه في باريس (سنة ١٩٤٥م) وعين في السنة ذاتها أُستاذاً للغة العربيّة والحضارة الإسلاميّة في كليّة الآداب بـ (باريس)، ووكيلاً لمعهد الدراسات الساميّة في جامعتها.
كان من أعضاء المجمعين: العلمي العربي بدمشق، واللغوي بالقاهرة، مات بـ (باريس)(سنة
____________________
(١) Journal Asiatique ومجلّة المجمع العلمي ٤: ١٦٤ ثمّ ٥: ١٦٩ والربع الأوّل من القرن العشرين: ١٢٣، والمستشرقون: ٦٣، ومكتبة فاروق الأوّل، فهرس التاريخ ٥٦. عن الزركلي، خير الدين - الأعلام (قاموس تراجم) م٣. وعن المنجد (الأعلام)، ص١١٢.
١٩٥٥م) تعاون مع محمّد بن أبي شنب على تصنيف (المخطوطات العربيّة في خزانة الرباط) وممّا نشر:
(كتابات عربيّة في اسبانيا) و(نص جديد للتاريخ المريني) و(اسبانيا المسلمة في القرن العاشر) و(الحضارة العربيّة في اسبانيا) و(وثائق غير منشورة عن تاريخ الموحّدين) و(منتخبات من مؤرّخي العرب في مراكش) و(البيان المغرب) لابن عذاري، و(مقتطفات تاريخيّة عن برابرة القرون الوسطى) و(أعمال الأعلام، القسم الثاني، في أخبار الجزيرة الأندلسيّة) لابن الخطيب، و(مذكرات الأمير عبد الله آخر ملوك غرناطة) و(صفة جزيرة الأندلس) اختزلهُ من الروض المعطار، و(سبع وثلاثون رسالة رسمية لديوان الموحدين) و(جمهرة انساب العرب) لابن حزم، و(نسب قريش) للزبيري(١) .
١٥ - كارل فلهلم سترستين( Karl Vilhelm Zetterstee,n ١٢٨٣ - ١٣٧٢هـ، ١٨٦٦ - ١٩٥٣م):
مستشرق سويدي، من العلماء، من أعضاء جمعيّات علميّة كثيرة، منها المجمع العلمي العربي، ولد في (أورسته) بالسويد وتخرّج (دكتوراً) في الفلسفة بجامعةأوبساله سنة ١٨٩٥م وعُين فيها أُستاذا للغات الساميّة، قام برحلات متعدّدة، وزار مصر والشام وتونس أكثر من مرّة.
تولّى تحرير مجلّة (العالم الشرقي)، وحضر عدّة مؤتمرات للمستشرقين، ترجم (القرآن) إلى اللغة السويديّة سنة ١٩١٧م، وصنّف بلغتهِ كتاب (اللغات الشرقيّة) و(تاريخ حياة محمّد) و(سياحة في شرق بلاد الفرس)، ومن أهم ما حققهُ ونشرهُ بالعربية (تهذيب اللغة) للأزهري، والجزآن الخامس والسادس من (طبقات ابن سعد) و(طرفة الأصحاب) للأشرف الرسولي، و(شمس العلوم) لنشوان الحميري، نشرَ منهُ جزأين وعهد إلى الأُستاذ (س. ديدرينغ) بإتمامه، و(تاريخ لسلاطين مصر
____________________
(١) المستشرقون ١: ٢٧٥، ودليل الأعارب: ٩١، ١٤٠، و poc راجع فهرستهُ في S – ٣ – ١١٧٩، وانظر مجلّة Arabica الجزء ٣ القسم ٢ - مايو ١٩٥٦م. عن الزركلي، خير الدين - الأعلام (قاموس تراجم) م٢.
والشام) لم يُعرف مصنّفهُ، و(معارج الأنوار النبويّة من صحاح الأخبار المصطفويّة) و(ألفيّة ابن مُعط الزواوي) في النحو، وغير ذلك، وكان يمضي مقالاته أحياناً باسم (عبد الرحمان) وعلى الأكثر بحروف اسمه الثلاثة K. V. Z أمّا اسم أبيه فهو(الكسندر موريس سترستين) (١) .
١٦ - جورجيو ليفي دلا فيدا ( G. Levi, Della Vida ١٣٠٣ - ١٣٧٨هـ، ١٨٨٦ - ١٩٦٧م):
من كبار المستشرقين الايطاليّين، مولدهُ ووفاته بـ (روما)، كان أُستاذ العربيّة واللغات الساميّة المقارنة في جامعتها، عمل في فهرست كتب الفاتيكان، وقد عُهد إليه في أعوامه الأخيرة بالكتابة عن المخطوطات النصرانيّة، ولمّا بلغ السبعين من عمره احتفل به العلماء وصنّفوا في تكريمه (كتاب الدراسات الشرقيّة) بالايطاليّة في مجلّدين كبيرين.
له كتابات كثيرة في دائرة المعارف الإسلاميّة والمجلاّت العلميّة. ومما حققهُ للنشر (طبقات الشعراء) لابن سلام و(شعر يزيد الأوّل) و(نسب فحول الخيل) لابن الكلبي، ومن تآليفه (فهرس المخطوطات العربيّة الإسلاميّة في مكتبة الفاتيكان) الجزء الأوّل بالايطاليّة، ولم يكمله(٢) .
١٧ - كارل فلّرس( Karl Vollers ١٢٧٣ - ١٣٢٧هـ، ١٨٥٧ - ١٩٠٩م):
مستشرق ألماني، تولّى إدارة المكتبة الخديويّة (دار الكتب المصريّة) مدّة. وكان من أساتذة جامعة (نيا) في ألمانيا، نشر بالعربيّة ديوان (المتلمس) مع ترجمة له ألمانيّة، وكتب بالألمانيّة (العربيّة العاميّة عند قدماء العرب) و(اللهجة العربيّة
____________________
(١) من ترجمة له بقلمه، في مجلّة المجمع العلمي العربي ٧: ٣٢٠ - ٣٣٤ وترجمة ثانية بإمضاء (الدكتور س. ديدرينغ)، في مجلّة المجمع أيضا ٢٩: ١٤٠ - ١٤٣. عن الزركلي، خير الدين - الأعلام (قاموس تراجم) - م٥.
(٢) انظر: المستشرقون ١: ٣٩٠ والمكتبة: العدد ٦٢ ص٢٣ والرسائل المتبادلة ٢١٨. عن الزركلي، خير الدين - الأعلام (قاموس تراجم) م٢.
في مصر) ووصف (المخطوطات الشرقيّة التي بمكتبة لا يبسيك) في مجلّد ضخم(١) . عُرف بافترائه أنّ القرآن الكريم لم يكن معرباً، وأنّ اللغويّين هم الذين حذوه على مثال لغة الشعر العربي الذي يتميّز بوجود الإعراب.
١٨ - فرانتس بول (بوهل)( Frantz Buhl ١٢٦٦ - ١٣٥١هـ، ١٨٥٠ - ١٩٣٢م):
مستشرق دانماركي، من أعضاء المجمع العلمي العربي، ولد وتوفّي في كوبنهاكن، كان أُستاذ اللغات الساميّة في جامعتها، كتب في دائرة المعارف الإسلاميّة فصولاً في تراجم بعض أعلام المسلمين، وله كتاب في (جغرافية فلسطين القديمة) باللغتين الدانماركيّة والألمانيّة، وكتاب (حياة محمّد) كتبه باللغة الدانماركيّة، وترجم إلى الألمانيّة، وكان واسع الاطّلاع بأدب الجاهليّة العربيّة وتاريخها(٢) .
١٩ - جاكب بارت( Jacob Barth ١٢٦٧ - ١٣٣٢هـ، ١٨٥١ - ١٩١٤م):
مستشرق ألماني، كان يدرّس العربيّة في الكليّة الاكليركيّة، في جامعة برلين، من كتبه بالألمانيّة (أبحاث في الشعر العربي القديم)، وكتاب في (الآداب العربيّة والعبريّة)، ونشر في العربيّة (ديوان القطامي) و(فصيح ثعلب)(٣) .
٢٠ - ج. هـ. كريمرز J. H. Kramers :
مستشرق هولندي كثير الطعن في الإسلام، وصاحب ميول تبشيريّة سافرة(٤) .
____________________
(١) الربع الأوّل من القرن العشرين ٨١ والمستشرقون ١١٣ ومعجم المطبوعات ١٦١٥. عن الزركلي، خير الدين - الأعلام (قاموس تراجم) م٥.
(٢) مجلّة المجمع العلمي ١٢: ٢٨٢ والمستشرقون ١٨١ واسمهُ الشائع بالعربيّة (فرانز) والدانماركيّون يلفظونه (فرانش) والهاء في لفظهم (بوهل) لا تكاد تظهر. عن الزركلي، خير الدين - الأعلام (قاموس تراجم) م٥.
(٣) المستشرقون ١١٥ ومعجم المطبوعات ٦٦٣، والربع الأوّل من القرن العشرين ص٨٣. عن الزركلي، خير الدين - الأعلام (قاموس تراجم) م٨.
(٤) د. البهي، محمّد - الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ص٥٤٧.
٢١ - أدوين كالفرلي E. Calverley :
مستشرق أميركي متعصّب، رئيس تحرير مجلّة (العالم الإسلامي) The Muslim World الأميركيّة فترة من الزمن، من الذين باشروا التدريس في الجامعة الأميركيّة بالقاهرة عدّة مرّات، معروف باتّجاهات تبشيريّة سافرة(١) .
٢٢ - پاول كراوس( Paul Kraus ١٩٠٤ - ١٩٤٤م):
مستشرق ألماني، من أصل تشيكوسلوفاكي، تعلم في جامعة براغ، وتلقّى العلوم الشرقيّة بجامعة برلين، وعُيّن في معهد التاريخ للعلوم بـ (برلين)، ثُمّ مدرّساً بجامعتها (سنة ١٩٢٣م) وانتدب للتدريس في السوربون بـ (باريس)، ثمّ أُستاذاً للغات الساميّة في جامعة فؤاد الأوّل (بمصر) سنة ١٩٣٦م، فأقام إلى أنْ مات منتحراً.
عُرف بكيده للإسلام خصوصاً في ما يتعلّق بادعائه أنّ القرآن كان غير مُعرب، وأنّ الذين حذوه على مثال لغة الشعر العربي المُعرب هُم اللغويّون.
له (رسالة في تاريخ الأفكار العلميّة في الإسلام) ثلاثة أجزاء، وله أيضاً( رسالة في فهرست كتب محمّد بن زكريّا الرّازي لأبي الريحان البيروني) نصٌّ وتعليق، وساعد ماسينيون على نشر (أخبار الحلاّج)، وله في دائرة المعارف الإسلاميّة دراسات عن المستنصر والرّازي وابن الراوندي وابن جُبير، وفي مجلّة الثقافة بمصر (سنة ١٩٤٤م) له مقالات عنوانها (من منبر الشرق) وغير ذلك(٢) .
بعد هذا الاستعراض السريع لأبرز المستشرقيّن، الذين تصدّوا أو ساهموا تحت إشراف المستشرق (فنسنك) في كتابة وتحرير موادّ دائرة المعارف الإسلاميّة، نلحظ بوضوح أنْ الجامع فيما بين توجّهاتهم وأبرز الخلفيّات التي
____________________
(١) عن د. البهي، محمّد - الفكر الإسلامي الحديث وصلتهُ بالاستعمار الغربي، ص٥٣٨.
(٢) المستشرقون: ١٩٣، ودليل الأعارب: ١٠٤ و١٠٦. عن الزركلي، خير الدين - الأعلام (قاموس تراجم). المجلّد ٢ ص٤٢. وعن الجندي، أنور - مخطّطات الاستشراق - مجلّة منار الإسلام - العدد ٧ - السنة ١٤.
تتحكّم في عقولهم وأقلامهم هي معاداة الإسلام، والتعصّب ضدّه باعتباره ديناً سماويّاً، لذا فإنّ بعضهم ينكر بصراحة أصل سماويّة الدين الإسلامي، والبعض الآخر يُحاول نَسف الأساس الذي يقوم عليه القول بسماويّته.
وبذلك نستطيع أنْ نخرج برؤية كلّيّة عن كتّاب ومحرّري هذه الدائرة، مفادها أنّهم يفتقدون النزاهة والموضوعيّة في تناول أُمّهات القضايا الإسلاميّة، خصوصاً ما يمتّ إلى أُصوله العقائديّة بصلة، وأنّهم في طريقة تناولهم لها يهدفون إلى زرع الشكّ بصحّة سماويّة الدين الإسلامي، وصحّة نزول الوحي الإلهي فيه على النبيّ محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وهذا ما نجده طافحاً في الكثير من مواد ومطالب دائرة المعارف الإسلاميّة، عند تناولنا للجانب التالي من دراستنا لها.
ودعماً لما ألمحنا له في بيان هُويّة وخلفيّة كتّاب هذه الدائرة والمشرفين على تحريرها، نُشير إلى أنّ الكثير من الباحثين المنصفين والمحقّقين المتخصّصين قد تصدّى لدراسة دائرة المعارف الإسلاميّة، وأشاروا إلى أنّها تحوي مجموعة من الأخطاء والدسائس الناشئة عن التعصّب الأوربّي، وأنّ أغلب كتّابها قساوسة مبشّرون لا يهمّهم سِوى الافتراء على الإسلام وتشويه حقيقتِه.
وقد أجمعت آراؤهم على أنّ دائرة المعارف الإسلاميّة تضمّ مجموعة من المحاذير، التي يجب التنبّه لها والتصدّي للردّ عليها وكشف أهدافها، وهي:
١ - سيطرة البدع الدخيلة في الدين الإسلامي على مواد الموسوعة باستفاضة مثيرة، وباستخدام أساليب الكذِب المتقنة، حتّى ليظنّ الباحث أنّها من أُصول الإسلام، وقد أمعن مؤلّفو الدائرة في تسجيلها وشرحها وكأنّها حقائق ثابتة ومن الأُصول المقرّرة والمسلّم بها وليسَ من الدخائل.
٢ - القصد المعتمد في المع بين أساطير البدع التي ما انزل الله بها من سلطان وحقائق الشريعة.
٣ - جمعت دائرة المعارف هذهِ خلاصة ما كُتبَ عن الإسلام في الكتب التي
ألّفها المستشرقون، والتي كانت السمة الغالبة عليها الهجوم بشراسة على الإسلام خلال السنوات الطويلة، وكانت متفرّقة في هذهِ المؤلّفات التي لم يكن يقرأها إلاّ بعض الغربيّين، الذين يُختارون للعمل في البلاد الإسلاميّة، ثُمّ جاءت الدائرة لتظمّ هذا كلّهُ، وتجعل منهُ مصدراً إسلاميّا يُرجع إليه بسهولةٍ ويُسر، بعدَ أنْ تُرجم أغلبها إلى العربيّة.
٤ - إصرار القائمين على هذهِ الدائرة على عدم التصحيح - ولو بالتعليق الهامشي - للأخطاء والمطاعن التي انكشف أمرها جليّاً، وهذا أكثر ضرراً من أشرّ كتب المبشّرين والمستشرقين وصحفهم؛ لأنّ هذهِ كلّها لا تخدع أحداً من أهل الحقيقة والمعرفة، إنّما خطر تلك يكمن في نشوء جيل من المتعلّمين يعتبرها مراجع موسوعيّة أساسيّة تضافرت عليها جهود عشرات العلماء والمفكّرين، فيستقي منها ويعتمد عليها دون أنْ يفرّق بين الحقّ والباطل فيها، أو يعلم أنّ مؤلّفي هذهِ الدائرة من ألدّ خصوم الإسلام والمسلمين.
الدسّ والتشويه في موادّها (شُبهات وردود)
في الجانب الثاني من جانبَي التقويم الرئيسيّين لدائرة المعارف الإسلاميّة، والخاص باكتشاف موارد الدسّ والتشويه الذي احتوته الدائرة المذكورة، تُوجد عدّة أقسام ينقسم إليها هذا الجانب، يختصّ كلّ قسم منها بموردٍ أساسي من الموارد الإسلاميّة التي طالتها يد الدسّ والتشويه الاستشراقي، وسنذكرها تباعاً حسب أهميّتها من خلال تتبّعنا التفصيلي لموادّ وفصول هذه الدائرة، محاولين بمقدار ما تدلّ عليه النصوص والمقولات المتضمّنة في تلك المواد والفصول، اكتشاف موارد الدسّ والتشويه، وما يكمن وراءها من أهداف ومقاصد، أمّا كيف ستتمّ لنا معالجة هذه الدسائس والتشويهات وردّ ما تحكيه من شُبهات كليّة، فهذا ما سننهج له منهجين:
المنهج الأوّل: وهو المنهج التفصيلي الذي سنُحاول من خلاله ردّ ومعالجة كلّ مفردة من مفردات الدسّ والتشويه بحسبها، دون الخوض في الكليّات الأساسيّة الجامعة لها والحاكية عنها، وسَنُضمّن هذه الردود والمعالجات في سياق تفصيلات الدسّ والتشويه التي نوردها ونؤشر لها في إطار تبويبات بحثنا هذا.
المهج الثاني: وهو المنهج الكلّي، وفيه نقوم بانتزاع عنوان كلّي عن كلّ مجموعة تفصيلات معبّرة عن شبهة أساسيّة معينة، ويتم ردّها وبيان الحق في مقابلها ضمن بحثٍ مستقلٍ بها، وهذا المنهج سوف نُرجئ أمره إلى ما بعد سوقنا لكافّة النماذج التفصيليّة للدسّ والتشويه، التي قام بها المستشرقون في دائرة المعارف الإسلاميّة، وساوقهم بها غيرهم من المبشّرين والعلمانيّين في كتاباتهم
المختلفة عن الإسلام والمسلمين.
وأدناه نشرع ببيان عُمدة نماذج الدسّ والتشويه في دائرة المعارف الإسلاميّة، وهي عبارة عن ادّعاءات ومقولات مدسوسة ومشوّهة تهدِف إلى الطعن بإلهيّة القرآن الكريم، ورسالة النبيّ محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بالإسلام.
وقد صيغت هذه الادعاءات والمقولات بأشكالٍ مختلفة، بعضها جاء صريحاً، وبعضها الآخر يدلّ بالدلالة الالتزاميّة على الطعن والتكذيب، ويمكننا تنظيمها وتحديدها بما يلي:
ذكاء محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وخياله عماد دعوته
وهو دسّ وتشويه يهدف إلى القول بأنّ ذكاء محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وخياله المتوقّد هما اللذان كانا وراء ما جاء به من دعوة.
ونجد مصاديق هذه الشبهة في عدّة موارد، منها ما جاء تحت مادّة (إبراهيم)، ففي معرض بيان دعوى(سنوك هجروينيه) بأنّ شخصيّة إبراهيم مرّت بأطوارٍ متناقضة في القرآن الكريم، والإشارة إلى السرّ في هذا الاختلاف يقول(فنسنك A. J. Wensinck ) : (إنَّ محمّداً كان قد اعتمد على اليهود في مكّة، فما لبِثوا أنْ اتخذوا حياله خطّة عِداء، فلم يكن له بدٌّ من أنْ يلتمس غيرهم ناصراً.
هناك هداه ذكاءٌ مسدّد إلى شأنٍ جديد لأبي العرب إبراهيم، وبذلك استطاع أنْ يخلّص مِن يهوديّة عصره ليصل حبله بيهوديّة إبراهيم)(١) .
ومنها ما جاء تحت مادّة (الله) الفقرة (ج): الله في ذاته لذاته، يقول
____________________
(١) دائرة المعارف الإسلاميّة ١: ٢٧.
(ماكدونالد D. B. Macdonald ):
(وقد استطاع محمّد بفضل خياله المتوقّد أنْ يصف الله بصفات واضحة معيّنة، مثل الأوّل والآخر، والظاهر والباطن (سورة الحديد - الآية ٣)، وأنّه القيّوم (سورة البقرة - الآية ٢٥٦)، (سورة آل عمران - الآية ١)(١) .
وفي معرض الردّ والمعالجة لهذه النصوص من الدسّ والتشويه نؤشّر أوّلاً إلى أنْ الأساس في مثل هذا الدسّ والتشويه والهدف من وراء إرجاع النجاح في خطوات دعوة النبيّ محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ومواقفه الرساليّة إلى ذكائه مثلاً أو خياله المتوقّد - كما يعبّرون - هو إنكارهم الوحي الإلهي للنبيّ محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) سنقوم ببحثه في فصل مستقل يستوعب جميع جوانب الإثارات التي ذكرناها عن المستشرقين، أو ما سيأتي منها في موارد وأبواب أخرى، وبصيغ وزوايا مختلفة.
أمّا ردّنا وعلاجنا لموارد الدسّ والتشويه التفصيليّة التي أوردناها في هذه الفقرة فنرتبه كالآتي:
١ - قول (فنسنك A. J. Wensinck ): إنّ محمّداً (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كان قد اعتمد على اليهود في مكّة، فهذا ما لم يقله ولم ينقله لنا أيّ مؤرّخ، سواء كان من المسلمين أم من غيرهم، بل الذي ورد هو العكس، حيث إنّ اليهود كانوا أوّل وأشدّ مَنْ نصب العِداء ومارس تأليب مشركي قريش، والتآمر على رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ودعوته الإسلاميّة، حتّى نزل في ذلك قرآن الكريمٌ، قال فيه الله تعالى:
( لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى.... ) (٢) .
____________________
(١) المصدر السابق ٢: ٥٦٢.
(٢) المائدة: ٨٢.
أمّا قوله: (وبذلك استطاع أنْ يخلص من يهوديّة عصره ليصل حبله بيهوديّة إبراهيم) ففيه:
أوّلاً: إنّ اليهوديّة المدّعاة التي كانت على عصر الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) هي انحراف عن الدين الحق، الذي بعث الله تعالى به أنبياء بني إسرائيل وعلى رأسهم موسى (عليه السلام)، وفي ذلك قال الله تعالى في محكم قرآنه الكريم:
( مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ... ) (١) .
وقوله تعالى أيضا: ( أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) (٢) .
ثانياً: إنّ الرسول محمّداً (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لم يكن بحاجة لأنْ يصل حبله باليهوديّة المدّعاة؛ لأنّ الأصل في الأديان هو الإسلام، وقد توالى بعث الرسُل والأنبياء من الله تعالى للتبشير به، وردّ التحريف عنه، والدعوة له قبل خاتمهم محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، أمّا النصرانيّة واليهوديّة المدّعَيتان فما هي إلاّ انحراف عن الأصل الإسلامي، وبدعة أملَتها عليهم أهواؤهم ودنياهم الرخيصة، وفي ذلك قول الله تعالى في القرآن الكريم:
( وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ) (٣) .
وهذه هي العقيدة التي دعا لها النبيّ محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وذكرها الله تعالى في القرآن الكريم بقوله:
( شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ * وَمَا تَفَرَّقُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا
____________________
(١) النساء: ٤٦.
(٢) البقرة: ٧٥.
(٣) آل عمران: ١٨٧.
جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ * فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ) (١) .
ثالثاً: إنّ نبيّ الله إبراهيم (عليه السلام) لم يكن يهوديّاً، لما قلنا من أنّ الأصل في الأديان المبشَّر بها هو الإسلام، وكيف يكون إبراهيم (عليه السلام) يهوديّاً أو نصرانيّاً حسب دعواهم وقد نزلت التوراة والإنجيل مِن بعده بزمنٍ مديد؟ وهو قول الله تعالى في قرآنه الكريم:
( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ إِلاَّ مِنْ بَعْدِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ * هَا أَنْتُمْ هَؤُلاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) (٢) .
ثُمّ ينفي الله عزّ وجلّ اليهوديّة والنصرانيّة المدّعيتين عن إبراهيم (عليه السلام) ويثبت كونه حنيفاً مسلماً لا غير، وذلك قوله عزّ من قائل في الكتاب الكريم:
( مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلاَ نَصْرَانِيّاً وَلكِن كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) (٤) .
٢ - قول (ماكدونالد D. B. Macdonald ): (وقد استطاع محمّد بفضل
____________________
(١) الشورى: ١٣ - ١٥.
(٢) آل عمران: ٦٥ - ٦٦.
(٣) آل عمران: ٦٧.
(٤) التوبة: ٣٣.
خياله المتوقّد أنْ يصف الله بصفات واضحة معيّنة،...) إلى آخر القول، ففيه ما في قول سابقه(فنسنك) من أنّه يوحي بأنّ الرسول محمّداً (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لم يكن قد أُوحي له من الله تعالى، إنّما هو الذكاء أو الخيال المتوقّد، رغم أنّ لفظهم لم يكن صريحاً في ذلك وسنؤجّل ردّه - كما اشرنا سلفاً - إلى بحثٍ مستقلٍ لاحق يستوعب الإثارات التي سيأتي ذكرها تباعاً في هذه الشبهة.
والظريف أنّ( ماكدونالد هذا قد اعترف بوضوح الصفات وجلاء معانيها رغم تناقضه في مقاطع أُخرى من أقواله في ذلك، يذكرها تحت نفس مادّة (الله) وسنأتي على بيانها تباعاً إنْ شاء الله).
تناقض القرآن والتردّد في بعض آياته
وقد تضمّنت هذه المقولة على دسّ وتشويه يهدف إلى إثارة شبهة أنَّ في القرآن تناقضاً وفي بعض آياته تردّداً، منها ما جاء تحت مادّة (إبراهيم)، يقول (فنسنك):( كان سبرنجر - Leben: Sprenger und Lehredes Mohammad ، ج٣، ص٢٧٦ وما بعدها - أوّل من لاحظ أنّ شخصيّة إبراهيم كما في القرآن مرّت بأطوار قبل أنْ تصبح في نهاية الأمر مؤسِّسَةً للكعبة، وجاء سنوك هجروينيه (٢٠ وما بعدها) بعد ذلك بزمن فتوسّع في بسط هذه الدعوى، فقال:
إنّ إبراهيم في أَقدم ما نزل من الوحي (الذاريات - آية ٢٤ وما بعدها، الحجَر - آية ٥ وما بعدها، الصافّات - آية ٨١ وما بعدها، الأنبياء - آية ٥٢ وما بعدها، العنكبوت - آية ١٥ وما بعدها) وهو رسولٌ من الله أنذر قومه كما تُنذر الرسُل، ولم تُذكر لإسماعيل صِلةٌ به، وإلى جانب هذا يُشار إلى أنّ الله لم يرسل من قبل إلى العرب نذيراً (السجدة - آية ٢، سبأ - آية ٤٣، يس - آية ٥)، ولم يُذكر قط أنّ إبراهيم هو
واضع البيت، ولا أنّه أوّل المسلمين، أمّا السوَر المدنية فالأمر فيها على غير ذلك، فإبراهيم يُدعى حنيفاً مسلماً، وهو واضع ملّة إبراهيم، رفع مع إسماعيل قواعد بيتها المحرّم - الكعبة - (البقرة - آية ١١٨ وما بعدها، آل عمران - آية ٦٠، ٨٤... الخ) ولمّا أخذت مكّة تشغل جلّ تفكير الرسول، أصبح إبراهيم أيضاً المشيّد لبيت هذهِ المدينة المقدّس) (١) .
وفي مورد آخر وتحت مادّة (إسرائيل) يدّعي (سنوك) تناقضاً آخر في نسبة يعقوب لإبراهيم، فيقول:( ويظهر أنّ محمّداً كان أوّل الأمر يعتبر يعقوب ابناً لإبراهيم فعندما زُفَّت البشرى لسارة يقول:
( ...فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ) الآية - ٧١ من سورة هود. سنوك هجروينيه، ص٣٢)(٢) .
وتحت مادّة (صالح) يقول (بول Fr. Buhl ): (وممّا يستلفت النظر بالإضافة إلى ذلك أنّ قصّتَي صالح وهود (انظر هذه المادّة) تناقضان الدعوة المألوفة، التي أتى بها محمّد في سوَر العهد المكّي، من حيث إنّه قال إنّه لم يُرسل من قبله نبيٌّ إلى العرب (سورة القصص، الآية ٤٦؛ سورة السجدة، الآية ٢؛ سورة سبأ، الآية ٤٣؛ سورة يس، الآية ٥)(٣) .
وحول الناسخ والمنسوخ كانت عباراتهم صريحةً ومباشرة في ادّعاء التناقض في آيات القرآن، حيث يقول (نولدكه Noldeke Sc. Hwally ) تحت مادّة (أُصول): (وكان هَمّ المفسّرين المتأخّرين التخلّص من المتناقضات العديدة الواردة في القرآن، والتي تُصوّر لنا تدرّج محمّد في نبوّته، إمّا بما عمدوا إليه من التوفيق فيما بينها، وأمّا بالاعتراف بأنّ الآيات المتأخّرة تنسخ ما قبلها، وذلك في
____________________
(١) دائرة المعارف الإسلاميّة ١: ٢٧.
(٢) المصدر السابق ٢: ١١١ - ١١٢.
(٣) المصدر السابق ١٤: ١٠٧.
الآيات التي يشتدُّ فيها التناقض بين تلك الآيات)(١) .
وجاء في موضع آخر تحت مادّة (عقيدة محمّد في الله): (وقد عرّف محمّد الله بأنّه الملك، المنتقم الغيور، وأنّه سيُحاسب الناس مِن غير شك ويُعاقبهم في اليوم الآخر، وبذا تحوّلت تلك الفكرة الغامضة عن الله إلى ذات لها خطر عظيم، وينبغي لنا الآن أن نتبسّط في الكلام على هذه الذات كما تصوّرها محمّد، ومن حسن التوفيق أنّ لوازم السجع حملته على وصف الله بعدّة صفات يتردّد ذكرها كثيراً في القرآن (سورة الأعراف - الآية ١٧٩، سورة بني إسرائيل - الآية ١١٠، سورة طه - الآية ٧، سورة الحشر - الآية ٢٤) وتبيّن شغف محمّد بهذه الصفات وشدّة تمسّكه بها.
وكانت الفطرة السليمة هي التي دفعت المسلمين بعد محمّد إلى جمع هذه الصفات وتقديسها، وهذه الصفات تعبّر عن حقيقة إله محمّد أحسن ممّا تعبّر عنها الصفات التي ذكرها علماء الكلام في القرون الوسطى، وهي تعيننا كثيراً في فهم وتحديد عبارات محمّد، المُبعثرة المتناقضة(٢) .
وفي موضع آخر يسوق (كارادي فو B. Carrade Vaux ) دعوى تناقض القرآن بصياغة وجود تردّد فيه كما في المقطع التالي تحت مادّة (جهنّم): (الظاهر إنّ القرآن قد تردّد بعض التردّد في مسألة خلود العذاب في جهنّم، فالآيات التي تشير إلى ذلك لا تتّفق تمام الاتّفاق، ولعلّ هذا التردّد إنّما يرجع إلى أنّ النبيّ محمّداً لم يكن من الفلاسفة المتفكّرين، فلم يستطع أنْ يعرض بوضوح المشكلة كمشكلةِ الخلود يدخل فيها مثل هذا التصوّر المجرّد)(٣) .
كما تأتي دعوى التردّد على سبيل الملازمة بين القرآن والتغييرات التي
____________________
(١) المصدر السابق ٢: ٢٧٣.
(٢) المصدر السابق ٢: ٥٦١.
(٣) المصدر السابق ٧: ١٩٨.
تحصّل في توجّهات النبيّ محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، حيثُ يقول(فنسنك) تحت مادّة(الخمر) :
(ولم يكن تحريم الخمر في برنامج النبيّ مُنذ البداية، بل نحن نجد في الآية ٦٧ من سورة النحل مدحاً في الخمر، بوصفها آيةً من آيات الله للناس وهذا نصّها: ( وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا... ) .
بيد أنّه قيل: إنّ عواقب السكر قد ظهرت على الصورة التي بيّنا، فدفع ذلك النبيّ إلى أنْ يغيّر من اتّجاهه، وأّول ما نزل من الوحي مبيّناً هذا الاتّجاه هو الآية ٢١٦(١) من سورة البقرة ونصّها:
( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا... ) على إنّ هذه الآية لم تعد تحريماً، ولم يغيّر الناس مِن عاداتهم وحدث أنْ اضطرب نظام الصلاة فنزلت آيةً أُخرى هي الآية ٤٦(٢) من سورة النساء:
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ... ) ومع ذلك فإنّ هذه الآية أيضاً لم تعد تحريماً مطلقاً للخمر حتّى نزلت الآية ٩٢(٣) من سورة المائدة فوضعت حدّاً للخمر: ( يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ ) (٤) .
إنّ الدسّ والتشويه الذي يوحي بشبهةٍ أنّ في القرآن تناقضاً وفي بعض آياته تردّداً فيه مغالطةً فاضحة من جهةٍ وجهلٍ أو تجاهل بطبيعة القرآن الكريم من جهةٍ أُخرى، وتوضيح ذلك بما يأتي:
١ - إن التطوّر المدّعى أو بتعبيرٍ أدق التدرّج الذي نجده في القرآن الكريم،
____________________
(١) في المصحف المتداول بين المسلمين الرقم الصحيح للآية المباركة ٢١٩.
(٢) في المصحف المتداول بين المسلمين الرقم الصحيح للآية المباركة ٤٣.
(٣) في المصحف المتداول بين المسلمين الرقم الصحيح للآية المباركة ٩٠.
(٤) دائرة المعارف الإسلاميّة ٨: ٤٥١.
سواء في آيات الإرشاد العقلي للجانب العقائدي أم آيات الأحكام الخاصّة بالتشريع الإسلامي، أم آيات الأخلاق والتربية لإعداد الفرد المؤمن والأُمّة المؤمنة، إنّما هو أمرٌ طبيعي اقتضته طبيعة الحكمة في الطرح الرسالي الهادف إلى توفير وإعداد عوامل الدعوة والبناء للإنسان والمجتمع، وليس كتاباً أكاديميّاً مدرسيّاً يصنّف موضوعاته بفصولٍ وأبواب تستوعب موضوعاتها مرّة واحدة، وحتّى الكتب المدرسيّة تخضع لمنهج التدرّج في طرح الحقائق والمعلومات، فتبدأ بالأوليّات والإجماليّات وتترقّى إلى الرتب الأعلى في العمق والتفصيل العلمي، فهذه الشبهة المدّعاة مغالطةٌ فاضحة مردودة على أصحابها من رجال الاستشراق، ومَنْ سار على نهجهم ورأيهم المتهافت.
٢ - إنّ القرآن الكريم نزل نجوماً فهو إضافة لكونه كتاب تربية وإعداد للرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) والأمّة المؤمنة كما ذكرنا أعلاه، هو أيضاً كتاب حركة وإرشاد وإحكام لقيادة الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لدعوة الناس للإسلام، فجاءت آياته بشكلٍ يرتبط بالزمان والمكان طبقاً للظروف والأحوال والمستجدّات، التي تفرزها طبيعة حركة الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في دعوته سَواء في الموضوع أم المنهج أم الأسلوب.
لهذا نجد أنّ لكلّ آية من آيات القرآن الكريم شأناً وسبباً للنزول له مدخليّة أساسيّة في تحديد ما تتضمّنه الآية، من طبيعةٍ للموضوع ومنهجيّةٍ لعرضه وأُسلوبٍ لبيانه، كما أنّ له دوراً أساسيّا في تأويل معاني الآيات ومداليلها، فأصحاب الشبهة من المستشرقين وأربّائهم يتجاهلون هذه الحقيقة أو يجهلونها على أقلّ تقدير لو أحسنّا الظن بهم.
وهكذا نميّز بين المركوز لديهم عن الكتاب الأكاديمي المدرسي، وبين القرآن الكريم باعتباره كتاب تربية ودعوة وحركة ارتبط بالزمان والمكان، لدعوة الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وحركته في المجتمع آنذاك.
٣ - وعلى ضوء الحقيقتين الآنفتين، فمن الطبيعي أنْ تجد قصص الأنبياء (عليهم السلام)
والأُمم السالفة خاضعة لتلكما الحقيقتين، فالأطوار التي أشار لها المستشرق(سبرنجر) وأمثاله في عرض ما يتعلّق بالنبيّ إبراهيم (عليه السلام) والنبيّ إسماعيل (عليه السلام) ومكّة المكرّمة مرتبط بتلكما الحقيقتين، حيث يجمل تارة ويفصّل أُخرى، ويعرض الحقائق مِن زاوية معينة مرّةً وبتفاصيلٍ جديدة مرّةً أُخرى، وهكذا حسب مناسبات الموضوع وارتباطه بدعوة الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وحركته التغييريّة في الأُمّة آنذاك.
فلا غرابة ولا تردّد ولا تناقض في آيات القرآن الكريم، بل الغرابة كلّها فيما يخرصون.
٤ - أمّا قول المستشرق (سنوك) تحت مادّة (إسرائيل): (ويظهر أنّ محمّداً كان أوّل الأمر يعتبر يعقوب ابناً لإبراهيم، فعندما زُفّت البشرى لسارة يقول: ( ...فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ) (١) ، فمردّه إلى قصور هؤلاء المستشرقين عن فهم لغة القرآن العربيّة، فعلى كلّ الأحوال اللغويّة في هذه الآية يكون التقدير هو:(فبشرناها بإسحاق ويعقوب من وراء إسحاق) .
وقد فهِم المفسّرون مِن مجيء هذه الجملة في هذا الموضع أنّها كانت لبيان أنّ إبراهيم سيبقى عقبه فهو سيولد له ويولد لولده أيضاً، بدليل قوله تعالى: ( وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً... ) (٢) .
وهكذا نجد أنّ هذه الآية توافق جميع الآيات التي تنقل لنا هذه الحقيقة، كما يرِد على قولهم أنّ محمّداً (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كان أوّل الأمر يعتبر يعقوب ابناً لإبراهيم في الآيات المكيّة، في حين أنّ الآيات المكيّة التي ذكرت هذا الأمر بما فيها الآية أعلاه - التي أوضحنا مدلولها - على خلاف ذلك المدّعى، فالآية(٦) من سورة يوسف المكيّة جاء في
____________________
(١) المصدر ٢: ١١١ - ١١٢.
(٢) النحل: ٧٢.
آخرها: ( ...وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آَلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) ، وهي بيان أنّ يعقوب ابن إسحاق وحفيد إبراهيم، وأيضا في الآية(٣٩) من سورة إبراهيم المكيّة ورد:
( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ) ولم يقل إسماعيل وإسحاق ويعقوب، وفي مسألة البشرى لسارة ورد في الآية(٢٨) من سورة الذاريات المكّيّة ذكر لولد واحد فقط:
( فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ ) . فأين التردّد وأين التناقض في آيات القرآن الكريم، فما لكم كيف تحكمون؟.
٥ - وقول (بول Fr. Buhl ): (إنّ قصّتي صالح وهود تناقضان الدعوة المألوفة التي أتى بها محمّد في سور العهد المكّي من حيث إنّه قال إنّه لم يرسل من قبله نبيّ إلى العرب...) إلى آخره، فهي كسابقاتها تمحّل غريب، وذلك لما يأتي:
أ - إن الآيات(١) التي استدلّ بها بول هذا، هي: الآية(٤٦) من سورة القصص التي جاء فيها:
( ..لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ... ) ، والآية(٢) من سورة السجدة التي جاء فيها:
( ..لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ... ) ، والآية(٤٣) من سورة سبأ والتي جاء فيها:
( وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ) ، والآية(٥) من سورة يس التي جاء فيها:
( لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ) ، حيثُ إنّ الكاتب قد استدلّ بها على عدم إرسال الرسُل وبعث الأنبياء قبل الرسول محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إلى العرب، وبهذا ادّعى اكتشاف تناقض بين هذه الآيات، والآيات التي أوردَت
____________________
(١) بعض أرقام الآيات التي جاءت في دائرة المعارف الإسلامية فيها اختلاف بمقدار رقم واحد - ناقص - عمّا هو في ترقيم الآيات المعروف في القرآن الكريم، وما كان خلاف ذلك نشير إليه، فالمفروض ملاحظة ذلك؛ لأنّنا ننقل النص كما هو في الأصل.
قصّتَي صالح وهود، وأنّهما نبيّان أُرسلا إلى عاد وثمود وهما من العرب.
وجواب ذلك واضح لمن يتأمّل في الآيات الأُولى، حيث إنّها لم تقصد بالقوم (العرب) عمومهم مُنذ البدء والى عصر دعوة محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وإنّما كانت تقصد ذلك الجيل الذي يستوعب قوم العرب المعاصرين لنبوّة محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وآباءهم القريبين، وهذا هو الواقع حقّاً، حيثُ انقطع الوحي الإلهي فترة من الزمن، ولم يُرسل رسول لهم او يظهر نبيّ بينهم، فلا تناقض بين الآيات الأولى والثانية.
ب - قول (بول Fr. Buhl ) في دعواه هذه من أنّ عدم إرسال الرسل وبعث الأنبياء للعرب مألوف في سور العهد المكّي، والواقع خلاف ذلك فهناك آياتٌ مكّيّة تصرّح ببعث الأنبياء وإرسال الرسل إلى العرب وكلّ الأقوام والأُمم، منها قوله تعالى: ( إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلا فِيهَا نَذِيرٌ ) (١) ، ومنها الآيات المكّيّة التي تتحدّث عن قصّتَي النبيَّين صالح وهود (عليهما السلام)، منها قوله تعالى:
( وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آَيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ... ) (٢) .
وقوله تعالى: ( وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ) (٣) ، وقوله تعالى: ( وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ مُفْتَرُونَ ) (٤) ، وقوله تعالى: ( كَذّبَتْ ثَمُودُ
____________________
(١) فاطر: ٢٤.
(٢) الأعراف: ٧٣ وما بعدها.
(٣) هود: ٦١ وما بعدها.
(٤) هود: ٥٠ وما بعدها.
الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ * إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ) (١) ، وقوله تعالى: ( كَذّبَتْ ثَمُودُ بِالنّذُرِ... ) (٢) ، وقوله تعالى: ( كَذّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ... ) (٣) والمثير للاستغراب أنّ(بول) نفسه قال: (وقد وردت قصّتا هذَين النبيَّين في أقدم السوَر المكّيّة، مثل سورة النجم الآية(٥١) وما بعدها، وسورة البروج الآية(١٧) وما بعدها، وسورة الفجر الآية(٨)، وسورة الشمس الآية(١١) وما بعدها، كما ترد كثيراً في السور التي تليها)(٤) .
ثُمّ أليست هذه الآيات قيوداً صريحة تشير إلى إرسال الرسُل وبعث الأنبياء للعرب لتنفي بذلك العموم المدّعى وتخصّصه بما قلناه أوّلاً من أنّه ينحصر بالمعاصرين والآباء القريبين؟ فمن الذي وقع في التناقض؟ هل هو القرآن الكريم؟ وقد أثبتنا بوضوح عدمه، أم هو(بول) وأضرابه من المستشرقين من الذين تكلفوا العلم وتمحّلوا دعوى المعرفة وما هم إلاّ يجهلون؟
٦ - قول (نولدكه N Ideke Sc. Hwally ) تحت مادّة(أُصول): (وكان هُمّ المفسّرين التخلّص من المتناقضات العديدة الواردة في القرآن). وقوله أيضاً: (والتي تُصوّر لنا تدرّج محمّد في نبوّته) إلى آخر مقولته في دعوى تناقض آيات القرآن الكريم، وفيه:
أ - إنّ (نولدكه) هذا ونظائره نتيجة قصورهم عن فهم كثير من مسائل علوم القرآن، ومنها مسألة الناسخ والمنسوخ هي التي دفعتهم لادّعاء وجود تناقض في آيات القرآن الكريم، دون تأمّلٍ ورجوعٍ إلى المتخصّصين في علم
____________________
(١) الشعراء: ١٤١ - ١٤٤ وما بعدها.
(٢) القمر: ٢٣ وما بعدها.
(٣) الحاقّة: ٤ وما بعدها.
(٤) دائرة المعارف الإسلاميّة ١٤: ١٠٧.
تفسير القرآن الكريم، بل ذهبوا كثيراً في الافتراء والتهمة عند صياغتهم لهذا الادّعاء باتّهامهم المفسّرين المتأخّرين بأنّ همّهم كان التخلّص من المتناقضات العديدة الواردة في القرآن، وكأن هذه التناقضات حقيقة واقعة واقعة لا مفرّ منها. وعليه فلابدّ لنا من إيضاح مختصر لحقيقة النسخ في القرآن الكريم.
النسخ في القرآن الكريم:
النسخ لغةً: النقل والإزالة والإبطال، وأنسب المعاني اللغويّة التي تنسجم مع فكرة النسخ، هي الإزالة لقول أهل اللغة: نسخ الشيب الشباب إذا أزاله وحلّ محلّه(١) ، ويدعم ذلك قوله تعالى: ( مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا... ) (٢) ، وقوله تعالى: ( يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ) (٣) ، وقوله تعالى: ( وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ) (٤) .
والذي ينسجم مع المحوِ والتبديل الوارد في هذه الآيات الكريمة هو معنى الإزالة، أمّا اصطلاحاً فقد عرّفهالسيّد الخوئي (قُدس سرّه) بأنّه: (رفع أمر ثابت في الشريعة المقدّسة بارتفاع أمده وزمانه، سَواء أكان ذلك الأمر المرتفع من الأحكام التكليفيّة - كالوجوب والحرمة - أم من الأحكام الوضعيّة كالصحّة والبطلان، وسَواء أكان من المناصب الإلهيّة أم من غيرها من الأُمور التي ترجع إلى الله تعالى بما أنّه شارع)(٥) ، وهذا التعريف يُخرِج من النسخ كلّ صور المخالفة في الظهور
____________________
(١) لسان العرب ٤: ٢٨ط بولاق.
(٢) البقرة: ١٠٦.
(٣) الرعد: ٣٩.
(٤) النحل: ١٠١.
(٥) البيان: ٢٧٧ - ٢٧٨.
اللفظي بين الآيات سُواء أكانت على نحو العموم والخصوص من وجه أم العموم المطلق، أم كانت إحداها مطلقة والأُخرى مقيّدة، التي تقوم بدور تفسير بعضها البعض الآخر، وقد كان المفسّرون المتقدّمون يدخلونها تحت عنوان النسخ مجازاً.
وبيان جواز النسخ عقلاً ووقوعه شرعاً، هو أنّ العقلاء من المسلمين وغيرهم أثبتوا جواز النسخ عقلاً ووقوعه شرعاً، وخالفهم في ذلك بعض اليهود والنصارى محاولةً منهم للطعن بإلهيّة الدين الإسلامي، وتمسّكاً بدوام الديانتين اليهوديّة والمسيحيّة، والشبهة التي يدّعيها المستشرق(نولدكه) وأمثاله، تتأسّس على نفس الرؤية والشبهة التي طرحها ذلك البعض من اليهود والنصارى، وجامع صياغتهم للشبهة هو قولهم: إنّ التناقض في القرآن ثابت لعدم جواز النسخ عقلاً، وعدم وقوعه شرعاً، فعدم جوازه عقلاً قائم على أساس استلزامه أحد أمرين باطلين:
الأوّل البَداء المستلزم للجهل والنقص،والثاني العبَث؛ لأنّ النسخ إمّا أنْ يكون بسبب حكمةٍ ظهرت للناسخ بعد أنْ كانت خفيّة لديه، أو أنْ يكون لغير مصلحةٍ وحكمة، وكلا هذين الأمرين باطل بالنسبة إلى الله سبحانه، ذلك أنّ تشريع الحكم من الحكيم فتقتضي تشريعه، حيث إنّ تشريع الحكم بشكل جزافي يتنافى وحكمة الشارع.
وحينئذٍ فرفع هذا الحكم الثابت لموضوعه بسبب المصلحة، إمّا أنْ يكون مع بقاء حاله على ما هو عليه من وجه المصلحة وعلم ناسخه بها، وهذا ينافي حكمة الجاعل وهو العبَث نفسه، وإمّا أنْ يكون من جهة جهله بواقع المصلحة والحكمة، وانكشاف الخلاف لديه على ما هو الغالب في الأحكام والقوانين الوضعيّة، وعلى كلا الفرضين يكون وقوع النسخ في الشريعة محالاً؛ لأنّه يستلزم المحال، إمّا الجهل أو العبَث وهما محالان على الله سبحانه لأنّهما نقصٌ ولا يتّصف بهما.
وفي الجواب عن هذه الشبهة لابد لنا من بيان مقدّمة وهي أنّ الحكم المجعول من قِبل الشارع ينقسم إلى قسمين:
الأول - الحكم المجعول الذي لا يكون وراءه بعث وزجر حقيقيّان، كالأوامر والنواهي التي تُجعل ويُقصد بها الامتحان ودرجة الاستجابة. وهذا ما نسمّيه بالحكم الامتحاني.
الثاني - الحكم المجعول الذي يكون بداعٍ حقيقي من البعث والزجر حيثُ يُقصد منه تحقيق متعلّقه بحسب الخارج، وهذا ما نسمّيه بالحكم الحقيقي. ونجد من السهل الالتزام بالنسخ في القسم الأوّل من الحكم، إذ لا مانع من رفع هذا الحكم بعد إثباته، بعد أنْ كانت الحكمة في نفس إتيانه ورفعه؛ لأنّ دوره ينتهي بالامتحان نفسه، فيرتفع حين ينتهي الامتحان ولحصول فائدته وغرضه.
والنسخ في هذا النوع من الحكم لا يلزم منه العبَث ولا ينشأ منه الجهل والنقص الذي يستحيل في حقّه تعالى.
وأمّا القسم الثاني من الحكم فإنّنا يُمكن أنْ نلتزم بالنسخ فيه، دون أنْ يستلزم ذلك شيئاً من الجهل أو العبث، حيث يُمكن أنْ نضيف فرضاً ثالثاً إلى الفرضين اللذين ذكرتهما الشبهة، وهذا الفرض هو أنْ يكون النسخ لحكمةٍ كانت معلومة لله سبحانه من أوّل الأمر ولم تكن خافيةً عليه، وإنْ كانت مجهولةً عند الناس غير معلومةٍ لديهم، فلا يكون هناك بَداء بالمعنى الذي يستلزم الجهل والنقص؛ لأنّه ليس في النسخ من جديد على الله لعلمه سبحانه بالحكمة مسبقاً.
كما أنّه لا يكون عبّثاً لوجود الحكمة في متعلّق الحكم الناسخ، وزوالها في متعلّق الحكم المنسوخ، وليس هناك ما يشكّل عقبةً في طريق تعقّل النسخ هذا، إلاّ الوهم الذي يأبى تصوّر ارتباط مصلحة الحكم بزمانٍ معيّن بحيث تنتهي عنده، وإلاّ الوهم الذي يرى في كتمان هذا الزمان المعيّن عن الناس جهلاً من الله بذلك الزمان. وهذا
الوهم يزول حين نلاحظ بعض النظائر الاجتماعيّة التي نرى فيها شيئاً اعتياديّاً ليس فيه من المحال أثر ولا من العبث والجهل.
فالطبيب حين يُعالج مريضاً ويرى أنّ مرحلة من مراحل المرض التي يجتازها المريض يصلح لها دواء معيّن، فيصف له هذا الدواء لمدّة معيّنة، ثمّ يستبدله بدواءٍ آخر يصلح لمرحلةٍ أُخرى لا يُوصف عمله بالعبث والجهل، مع أنّه قام بوضع أحكام معيّنة لهذا المريض في زمانٍ محدود، ثمّ رفعها عنه بعد مدّة من الزمن.
وحين وضع الحكم كانت هناك مصلحةٌ تقتضيه، كما أنّه حين رفع الحكم كانت هناك مصلحةٌ تقتضي هذا الرفع، وهو في كلّ من الحالين كان يعلم المدّة التي يستمرّ بها الحكم والحكمة التي تقتضي رفعه، ونظير هذا يُمكن أنْ نتصوّره في النسخ، فإنّ الله سبحانه حين وضع الحكم المنسوخ وضعه من أجل مصلحةٍ تقتضيه، وهو سبحانه يعلم الزمان الذي سوف ينتهي فيه الحكم، وتتحقّق المصلحة التي من أجلها شُرِّع، كما أنّه حين يستبدل الحكم المنسوخ بالحكم الناسخ يستبدله من أجل مصلحةٍ معيّنةٍ تقتضيه.
فكلٌّ مِن وضْع الحكم ورفْعه كان من أجل حكمةٍ هي معلومةٌ عند جعل الحكم المنسوخ، فليس هناك جهلٌ، كما أنّه ليس هناك عبَث لتوفّر عنصر العلم والحكمة في الجعل والرفع.
نعم هناك جهل الناس بواقع جعل الحكم المنسوخ، حيثُ كان يبدو استمرار الكم نتيجةً للإطلاق في البيان الذي وضع الحكم فيه، ولكن النسخ إنّما يكون كشفاً عن هذا الواقع الذي كان معلوماً لله سبحانه من أوّل الأمر، أمّا وقوع النسخ شرعاً فإنّه يتحقّق في موارد عديدة سَواء في الشريعة الموسويّة أو الشريعة المسيحيّة أو الشريعة الإسلاميّة، فقد جاءت نصوص في التوراة والإنجيل وفي الشريعة الإسلاميّة تتضمّن النسخ، ورفع ما هو ثابت في نفس الشريعة أو في غيرها من الشرائع السابقة، منها:
١ - تحريم اليهود العمل الدنيوي يوم السبت، مع الاعتراف بأنّ هذا الحكم لم يكن ثابتاً في الشرائع السابقة، وإنّما كان يجوز العمل في يوم السبت كغيره من أيّام الأُسبوع(١) .
٢ - أمر الله سبحانه بني إسرائيل قتل أنفسم بعد عبادتهم العجل، ثمّ رفعه لهذا الحكم عنهم بعد ذلك(٢) .
٣ - الأمر ببدء الخدمة في خيمة الاجتماع في سنّ الثلاثين، ثمّ رفع هذا الحكم وإبداله بسنّ خمسٍ وعشرين سنة، ثمّ رفعه بعد ذلك وإبداله بسنِّ العشرين(٣) .
٤ - النهي عن الحلف بالله في الشريعة المسيحيّة مع ثبوته في الشريعة الموسويّة، والإلزام بما التزم به في النذر أو اليمين(٤) .
٥ - الأمر بالقصاص في الشريعة الموسويّة(٥) ، ثمّ نسخ هذا الحكم في الشريعة المسيحيّة ونهي عن القصاص(٦) .
٦ - تحليل الطلاق في الشريعة الموسوية(٧) ، ونسخ هذا الحكم في الشريعة المسيحيّة(٨) .
أما النسخ في الشريعة الإسلاميّة فهو أمر ثابت لا يكاد يشكّ فيه أحد من علماء المسلمين، سَواء في ذلك ما كان نسخاً لأحكام الشرائع السابقة أم ما كان
____________________
(١) انظر سِفر الخروج ١٦/ ٢٥ - ٢٦ و٢٠/ ٨ - ١٢ و٢٣/ ١٢ و١٣/ ١٦ - ١٧ و٣٥/ ١ - ٣ وسِفر اللاويين ٢٣/ ١ - ٣ وسِفر التثنية ٥/ ١٢ - ١٥.
(٢) سِفر الخروج ٣٢/ ٢١ - ٢٩.
(٣) سفر العدد ٤/ ٢ - ٣ و٨/ ٢٣ - ٢٤. وسِفر أخبار الأيّام الأوّل ٢٣/ ٢٤ و٣٢.
(٤) سِفر العدد ٣٠/٢. إنجيل متّى ٥/ ٣٣ - ٣٤.
(٥) سِفر الخروج ٢١/ ٢٣ - ٢٥.
(٦) إنجيل متّى ٥/ ١٣٨.
(٧) سِفر التثنية ١٤/ ١ - ٣.
(٨) إنجيل متّى ٥/ ٣١ - ٣٢، وإنجيل مرقس ١٠/ ١١ - ١٢.
نسخاً لبعض أحكام الشريعة الإسلاميّة نفسها.
ومن هذا النسخ ما صرّح به القرآن الكريم كنسخه حكم التوجّه في الصلاة إلى القبلة الأولى (المسجد الأقصى)، القبلة الثانية في الشريعة الموسويّة، وأمره بالتوجّه شطر المسجد الحرام(١) .
ب - إنّ قول(نولدكه)، في تفسير المتناقضات التي يدّعي ورودها في القرآن، من أنّها تصوّر لنا تدرّج محمّد في نبوّته، تشويه فاضح يفتقر إلى المنطق السليم والموضوعيّة العلميّة ويكشف عن روح التحامل، إذ إنّه لا يستفرغ الوسع في البحث العلمي عن الحقائق، إنماّ يطويه سريعاً لينتقل إلى ما يحكيه إليه ميلهُ من تفسير وتعليل، فيغمز في نبوّة محمّد ابتداءً ويصوّرها على أنّها كانت متدرّجة، بدليل أنّ الآيات القرآنيّة بدأت متناقضة؛ لأنّ نبوّة محمّد بدواً لم تتحقّق.
وهكذا يترك قارئه في دوّامة الشك والتردّد. وقد أوضحنا في الفقرة السابقة ما هو ثابتٌ من حقيقة النسخ في القرآن الكريم، كما هو في الشرائع السماويّة السابقة، وما هي المصلحة فيه، فلا متناقضات في القرآن، وبالتالي تبطل شبهة(نولدكه) واحتمالاته في تدرّج نبوّة محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم).
٧ - قولهم تحت مادّة (عقيدة محمّد في الله)، بعد كلامٍ لهم في تعريف محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لصفات الله سبحانه: (... وهي تعيننا [الصفات] كثيراً في فهم وتحديد عبارات محمّد المُبعثرة المتناقضة)، هي صورةٌ جديدة من صور دعوى التناقض في القرآن الكريم، غير تلك التي تناولْنا الجواب عنها في مسألة النسخ في القرآن، وفي الردّ عليهم نقول:
أ - إنّكم لم تبيّنوا لنا موارد التناقض في صفات الله الواردة في القرآن
____________________
(١) لمزيد من التفصيل: راجع علوم القرآن للسيّد محمّد باقر الحكيم، والتمهيد في علوم القرآن للشيخ محمّد هادي معرفة.
الكريم، فدعواكم هذه مجملةٌ وغامضة لا وضوح فيها.
ب - إذا كان قصدكم من التناقض هو ما بين الصفات الكماليّة المتقابلة معنىً لله سبحانه، كالغفور الرحيم والمنتقم شديد العقاب، فجوابه، إنكمأولاً: يجب أنْ تحيطوا بحقيقة عقيدة التوحيد والعدل الإلهي، التي أرشد إليها القرآن الكريم في آيات الإرشاد العقائدي، والتي تعتبر صفات الله الكماليّة عين ذاته لا شيئاً خارجاً عنها، موصوفاً سبحانه وتعالى بها ( سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا يَصِفُونَ ) (١) ، فيها تتجلّى معرفة الكمال المطلق الذي يسعى الإنسان للتكامل في طريقه المستقيم.
وثانياً: إنّ هذه الصفات المتقابلة ليست متناقضة؛ لأنّها تختلف باختلاف متعلّقها، فالله سبحانه وتعالى غفورٌ رحيمٌ لمن اقتضى لطفه وحكمته رحمته والمغفرة له، وهو منتقمٌ شديدُ العقاب لمن اقتضى عدله وحكمته الانتقام منه وتشديد العقاب عليه، وهكذا شأن الصفات الكماليّة الأُخرى، فلا تناقض فيها ولا غموض ( سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ *وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) (٢) .
٨ - قول (كارادي فو B. Carrad Vaux ) تحت مادّة (جهنّم):( الظاهر أنّ القرآن قد تردّد بعض التردّد في مسألة خلود العذاب في جهنّم، فالآيات التي تشير إلى ذلك لا تتّفق تمام الاتّفاق، ولعلّ هذا التردّد إنّما يرجع إلى أنّ النبيّ محمّداً لم يكن من الفلاسفة المتفكّرين... الخ) فيه ما يلي:
أ - إنّ المقطع الأوّل الذي يشير إلى دعوى تردّد بعض آيات القرآن الكريم، في مسألة خلود العذاب في جهنّم جاء ناقصاً لا يتضمّن دليلاً أو مثالاً على التردّد المدّعى، فهو جزافي لا قيمة علميّة له.
____________________
(١) الأنعام: ١٠٠.
(٢) الصافّات: ١٨٠ - ١٨٢.
ب - إنّ العذاب الإلهي في الآخرة له درجات تتناسب ومستوى الجريمة التي ارتكبها الإنسان في الدنيا، فهي تتدرّج من المعاصي والمفاسد على اختلاف خطرها وعظمها، إلى الشرك والكفر والطغيان جحوداً بالله وإنكاراً لإلوهيّته والاستكبار والعلو في الأرض دونه سبحانه وتعالى.
ولهذا جاءت آيات القرآن الكريم لتؤكّد الخلود والشدّة في العذاب، لدرجات القسم الثاني ودون ذلك في القسم الأوّل، وهنا يأتي دور تفسير بعض الآيات للبعض الآخر تحصيصاً لعمومها وتقييداً لإطلاقها، إنْ كان هناك مخصّص أو مقيِّد لموردها، فيمتاز بعضها بالقول بالخلود في العذاب، وبعضها الآخر بما دون ذلك، فلا تردّد ولا تناقض عند أُولي الألباب.
ج - إنّ تعليل(كارادي فو) دعواه بتردّد القرآن في مسألة خلود العذاب في جهنّم، بأنّه يرجع إلى أنّ النبيّ محمّداً لم يكن من الفلاسفة المتفكّرين، فيه: أوّلاً: غمزٌ بنبوّة محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وهذا ما أجلنا الحديث فيه إلى فصل مستقل إنْ شاء الله.
وثانياً: لما قلنا سابقاً من أنّ القرآن الكريم ليس كتاباً مدرسيّاً، ولا مؤلّفاً أكاديميّاً يعرض المسائل بطريقة تحليليّة متسلسلة، وبلغةٍ مدرسيّة ومنهجٍ أكاديمي مقرّر، إنّما هو كتاب دعوة وتربية للإنسان والأُمّة، وإرشاد وقيادة لحركة الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) الميدانيّة عند بعثته وطيلة حياته الرساليّة، وفهم القرآن واستنباط الحقائق والأحكام والتعليمات منه، يحتاج إلى الإحاطة بجملة مقدّمات وقواعد تسمّى بعلم تفسير القرآن الكريم، الذي يتناول علوماً فرعيّةً متعدّدة تحقّق القدرة على التفسير والتأويل للقرآن، منها علوم اللغة وعلوم القرآن، وعلم الحديث، وأمثال ذلك.
وإنّما اضطررنا لهذه العلوم لابتعادنا عن زمن التنزيل، حيث إنّ وجود الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأهل بيته الطاهرين (عليهم السلام)، كان يُغني المسلمين آنذاك عن الإحاطة التفصيليّة بهذه العلوم؛ فقد كان الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأهل بيته (عليهم السلام) تراجمة القرآن وعلماء
حقائقه ودقائقه، ثمّ إنّ بلاغة القرآن وبيانه كانت واضحةً لدى المسلمين في عصر الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، لتذوّقهم الفطري لها، كما أنّ معاصرتهم للحوادث والوقائع التي تشكّل شأن وأسباب النزول، كانت تغنيهم عن البحث والاستقصاء عنها لمعرفة مدلول الآيات النازلة بشأنها، وهذا أمرٌ يدركه العقلاء ويلتزمون بلوازمه، فيبطل التعليل كما تبطل الدعوى.
٩ - قول(فنسنك) تحت مادّة(الخمر) : (ولم يكن تحريم الخمر في برنامج النبيّ منذ البداية، بل نحن نجد في الآية(٦٧) من سورة النحل مدحاً في الخمر بوصفها آيةً مِن آيات الله للناس...، بيد أنّ عواقب السكْر قد ظهرت على الصورة التي بيّنا، فدفع ذلك النبيّ إلى أنْ يغيّر من اتجاهه)، فيه ما يلي:
أ - غمزٌ بنبوّة محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وبصدق الوحي الإلهي له(١) ، وإلاّ فليس القرآن الكريم كلام النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ليبرمجه حسب رأيه، إنّما هو كلامٌ الله أنزله نجوماً على رسوله محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، بواسطة الوحي حسب مقتضيات الحكمة الإلهيّة ومناسبات حركة الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ودعوته للإسلام.
فبرنامج التحريم للخمر - حسب قول(فنسنك) - ليس إلاّ تدرّجاً في طريقة ومستوى البيان للحكم الشرعي، مِن تقبيح وتحريم له مرّةً، وبيان لاشتماله على الإثم - وهو محرّم - أُخرى، والزجر عن تناوله لحرمته ثالثة...، ولا تعارض بين الآيات التي تناولت الخمر، فكلّها تحرّمه بصيَغٍ بيانيّةٍ متنوّعة اقتضتها تلك الحكمة الإلهيّة والمناسبات الواقعيّة، شأنها في ذلك شأن كثير من الظواهر الاجتماعيّة الفاسدة، التي تستلزم تدرّجاً زمنيّاً في طريقة ومستوى بيان الموقف الشرعي الكامل منها، وبالشكل الذي يتناسب وقابليّة التلقّي الذهني والنفسي لمجتمع الدعوة والرسالة لهذا التشريع أو ذاك،
____________________
(١) وجواب هذه الشبهة سيأتي لاحقاً.
ليتحقّق الهدف الإلهي في إدراك الناس له وتحصيل الاستعداد للتسليم به، وهذه سنّة الله في رسالاته وشرائعه للأمم السالفة (كاليهوديّة والنصرانيّة) والتي ألمحنا لأمثلتها في بحث النسخ في القرآن الكريم في الفقرات السابقة من هذا البحث(١) .
ب - أمّا قوله: (إنّ في الآية ٦٧ من سورة النحل مدحاً في الخمر بوصفها آيةً من آيات الله للناس...) فليس كذلك، ولعلّ السبب في سوء الفهم هذا، هو روح التحامل على الإسلام من جهة - خصوصاً عند(فنسنك) المعروف بذلك - وعدم الإحاطة باللغة العربيّة من جهة أُخرى، فالآية الكريمة مكيّة وهي تخاطب المشركين وتجيبهم في سياق الظواهر الطبيعيّة التي يعايشونها في حياتهم الاعتياديّة، عن سؤالهم المقدّر وهو:
ما هي ثمرات إنزال الماء من السماء؟ فكون اتّخاذ المشركين السُكْر من ثمرات النخيل والأعناب لا يعني تحسينه لهم، خصوصاً وأنّ الآية الكريمة تنسب السُكْر إليهم وأنّه من صنعهم، وليس هو إلاّ إشارة إلى ثمرةٍ طبيعيّةٍ مألوفة لديهم، بل هناك قرينة واضحة في الآية تدلّ على نوع من تقبيح السُكْر من جهة مقابلته بالرزق الحسن، فلو كان السُكْر حسناً لما ميّزَته الآية الكريمة عن الرزق الحسن.
____________________
(١) هناك مَنْ يرى أنّ في الآيات التي تناولت الخمر ناسخاً ومنسوخاً، وعلى هذا الرأي يأتي كلامنا السابق في النسخ في القرآن الكريم وتنتفي بذلك دعوى فنسنك. راجع الطباطبائي - تفسير الميزان ١٢: ٣٠٩ - ٣١٠، ٢: ٢٠١ - ٢٠٥.
تأثّر محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) باليهوديّة والنصرانيّة والجاهليّة واستقاؤه منها في صياغة قرآنه ودينه الجديد
ولإبراز هذه الشبهة، دسّ العديد من محرّري دائرة المعارف الإسلاميّة ادعاءات ومقولات متنوّعة:
منها: ما جاء تحت مادّة (جبريل) حيثُ يقول (كارادي فو Carrade Vaux ): (وقد اصطنع النبيّ القصّة التي تقول بأَنّ هذا الرسول السماوي يتحدّث إلى الأنبياء واعتقد أنّه تلقّى رسالته ووحيه منه...
والظاهر أنّ النبيّ عرف جبريل من خبر البشارة الوارد في الإنجيل ولكنّه لم يكن في مقدوره أنْ يعرف الإنجيل من غير وساطة، ولعلّه سمع ذلك الخبر من أفواه بعض الفلاسفة أو الباحثين في الأديان، أو من أحد الحنفيّة وقد وصلهم الخبر مشوّهاً. وفي رأي النبيّ أنّ الله بعث بروحه إلى مريم فتمثّل لها بشراً سويّاً (سورة مريم الآية ١٩)(١) .
وتحت مادّة (سحر) يقول (هيك T. W. Haig ): (... إنّ أصول الإسلام نفسها قد تأثرت تأثراً عميقاً بمعتقدات أناس غرباء عن الإسلام كليّة)(٢) .
وتحت مادّة(أُمّة) يقول (ر. پاريه R. Paret ): (هي الكلمة التي وردت في القرآن للدلالة على شعب أو جماعة، وهي ليست مشتقة من الكلمة العربيّة(أمّ) ، بل هي كلمة دخيلة مأخوذة من العبريّة(أُمَّا) أو من الآرامية(أُمِّثا)، .. وقد تكون الكلمة الأجنبيّة دخلت لغة العرب في زمن متقدّم بعض الشيء. ومهما يكن من شيء فإنّ محمّداً أخذ هذه الكلمة واستعملها وصارت منذ ذلك الحين لفظاً
____________________
(١) راجع: دائرة المعارف الإسلاميّة ٦: ٢٧٦ - ٢٧٨.
(٢) المصدر ١١: ٣٠٥.
إسلاميّاً أصيلاً)(١) .
وتحت مادّة (السامرة) يقول (كاستر M. Gaster ): (... على إنّني لا أتردّد في القول بأنّ مقارنة أُصول العقيدة السامريّة بأُصول العقيدة الإسلاميّة، سيُبيّن أنّ السامرة قد أثّروا أثراً عميقاً في تكييف الدين الذي جاء به محمّد وإظهاره في الصورة التي تجلّى بها. وكان السامرة أبعد من أنْ يتأثّروا بمحمّد، ولكن السامرة أنفسهم هُم الذين أثّروا فيه)(٢) .
وتحت مادّة(السامرة) أيضاً يقول(كاستر) : (... زد على ذلك أنّ أوّل عبارة في القرآن هي باسم الله، ولهذه العبارة شأنٌ خاص، فقد جرى المسلمون على استعمالها في كلّ أمرٍ من أُمور دينهم، والحقّ أنّ كلّ شعيرة من شعائر الإسلام تبدأ بها، وليست هذه العبارة ابتهالاً مباشراً إلى الله، ولكنها دعوة باسمه القويّ القدير، وهي جزءٌ من الصوفيّة اليهوديّة والسامريّة، وهي أيضاً الأصل في معظم التكهّنات السحريّة عند القدماء.
وما كانت هذه المعرفة لتتيسّر للنبيّ إلاّ عن طريق اليهود أو النصارى عامّة، والسامرة خاصّة، ثُمّ استُعمل هذه العبارة على النحو الذي عرفنا، وافتتح بها أوّل آية من آيات القرآن... على أنّها تصبح مفهومة إذا ما قارنّاها بالدعاء السامري الذي يناظرها: (بسم الله نبدأ ونختم) أو في رواية أُخرى: (باسم الله نبدأ أو نُقبل) وهذه الصيغة هي التي يستعملها السامرة دائماً، وهي ترد في مستهلّ الـ(كينوش) الذي يجمع بين دفّتيه أقدم الصلوات والتراتيل، وفي مستهلّ الحجاب القديم لليهود، كما ترد في بداية كلّ شيء.
واختصرت هذه العبارة بتمامها بمرور الزمن من كثرة الاستعمال، وبلغت محمّداً بهذه الصيغة التي حُذِفَ منها جزؤها الثاني، لأنّه أصبح معروفاً ومفهوماً حقّ الفهم، ولكنّها كانت في
____________________
(١) المصدر ٢: ٦٣٠ - ٦٣١.
(٢) راجع المصدر ١١: ٩١ - ٩٦.
الحقّ بداية صيغة ليس لها معنى إذا لم تتم، ومع ذلك فإنّها تعتمد على نظريّةٍ كانت جديدة على العالم الإسلامي، ونعني بها الطبيعة الصوفيّة لاسم الله)(١) .
وتحت نفس المادّة يقول كاستر: (... قال أبو الفتح: إنّ ثلاثةَ حكماء من أهل التنجيم تنبّأوا بظهور محمّد ونجاح رسالته، وكان أحدهم يهوديّاً، والثاني مسيحيّاً، والثالث سامريّاً، وقد ذهبوا جميعاً إلى محمّد لينبّئوه بما سيكون له من شأنٍ عظيم، وتأثّر النبيّ بمقالهم وقَبِل نبوءاتهم شاكراً، واستطاع أنْ يهدي اليهود والنصارى إلى دينه.
أمّا اليهودي فكان(كعب الأحبار) المشهور، وأمّا النصراني فكان(آب سَمْلِيَهْ)، على أنّ السامري أبى أنْ يدخل في الدين الجديد، وإنْ كان قد استطاع أنْ يؤثّر في النبيّ أكثر من صاحبيه...
وهؤلاء الحكماء الثلاثة يمثّلون، خير تمثيل، الأديان الثلاثة التي كان لها شأنٌ في تكييف الإسلام)(٢) ، ويستمرّ كاستر في ادّعاءاته فيقول: (إنّا لنتساءل إلى أيّ حدٍّ أثّر السامرة في الإسلام؟ الواقع إنّ هذه الدعوى التي نطرحها الآن بالنسبة للسامرة دعوى جديدة، وحسبنا أنْ نختار وجوهاً قليلة منها، وهي الوجوه التي تستطيع أنْ تجد الدليل على وجودِ أصلٍ سامريٍّ لها...)(٣) .
ويستطرد كاستر في اختيار الوجوه تلك، منها قوله: (... وإنّي لأبدأ بالشهادة المعروفة في الإسلام:(لا اله إلاّ الله) ، وهذه الشهادة تنطبق بقدر ما تحتمل العقائد الدينيّة على العبارة التي كان يردّدها مراراً وتكراراً(مَرْقح) ومعاصروه(عَمْرام درا) و(نانا): (ليت اله إلا إماد) ... ومعناها ليس إله إلاّ أحد، وكانت وحدانيّة في نظر السامري كما كانت في نظر اليهودي وفي نظر محمّد
____________________
(١) المصدر ١١: ٩١ - ٩٢.
(٢) المصدر ١١: ٩٠.
(٣) المصدر نفسه.
أيضاً ركن دينه الركين)(١) .
وفي مادّة (تميم الداري) يقول (ليفي دلافيدا G. Levi Dellvida ): (... وكان تميم نصرانيّاً كغالبِ عرب الشام، فاستطاع أنْ يُخبر النبيّ بتفاصيل العبادات التي استعارها من النصارى... ويُقال: إنَّ تميماً كان أوّل من رَوى القصص الديني... وقد أخبر بها تميم النبيّ فأخذ بروايته وأذاعها في الناس)(٢) .
وعن دعوى استقاء الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من التوراة يقول (هورفتز J. Horovitz ) تحت مادّة(التوراة): (وفي القرآن إلى جانب مثل هذه الإشارات البيّنة إلى التوراة، قصص وأحكام استقاها منها وردّدها في مواضع كثيرة، دون أنْ يذكر المصدر الذي نقل عنه، وقد ساق أغلب هذا القصص في صيغته الهجاديّة(٣) وحوّر بعضه بحيث يُلائم أغراض محمّد الخاصّة)(٤) .
وتحت مادّة (جهنّم) يُحاول (كارادي فو B. Carrade Vaux ) من خلال تعريفه لها أنْ يطعن بإلهيّة القرآن الكريم ورسالة النبيّ محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بالإسلام فيقول: (جهنّم: وهي كلمة مشتقّة من اللفظ العِبري(جيحنّون) أو(وادي هنوم)، (انظر سِفر يوشع، الإصحاح الخامس عشر، الفقرة ٨) وكان وادياً بالقرب من بيت المقدّس، تُقدّم فيه القرابين إلى مولك في أيّام العقوق، وكلمة(جهنّام) بألفٍ بعد النون معناها البئر العميق.
وقد تردّد ذكر جهنّم وفكرة جهنّم كثيراً في القرآن إمّا لأنّ محمّداً نفسه قد بدهته هذه الفكرة وإمّا لأنّه رأى أنّه من المفيد أنْ يلحّ في ذكرها
____________________
(١) المصدر نفسه.
(٢) المصدر ٥: ٤٨١.
(٣) هكذا وردت في الأصل، وليس لهذه الكلمة معنى في معاجم اللغة، إلاّ أنْ تكون مشتقّة خطأً من كلمة (تهجّد) ولا صحّة لهذا الاشتقاق لا لفظاً ولا معنىً يلائم الجملة.
(٤) المصدر ٦: ١ - ٢.
لتفعل فعلها في مشاعر السامعين)(١) .
وتحت مادّة (دنيا) يُحاول (كارادي فو) مرّة أُخرى أنْ يطعن بإلهيّة القرآن الكريم، ويُؤكّد أن محمّداً (صلّى الله عليه وآله وسلّم) استقى آيات قرآنه من اليهوديّة والمسيحيّة، فيقول:( ... وأُسلوب محمّد في استعمال هذه الكلمة يذكّرنا تماماً بأُسلوب وعّاظ النصارى: ( أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآَخِرَةِ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ ) (سورة البقرة - الآية٨٠)(٢) ، وجاء في القرآن أيضاً (سورة الأعلى، الآيات من ١٦ - ١٩):
( بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدّنْيَا *وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى *إِنّ هذَا لَفِي الصّحُفِ الأُولَى *صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ) ، ونحن نستدلّ من هذه الآيات أنّ محمّداً لم يدّعِ أنّه أتى بجديد وهو يلقي بمواعظ من هذا القبيل، على أنّ الشيء الذي يُنسب لليهوديّة يجب أنْ يُنسب إلى المسيحيّة)(٣) .
وتحت مادّة(السكينة) يُحاول (جويل B. Joel ) من خلال دعوى استعارة هذه الكلمة من العبريّة، واقترانها بتصوّرات من العقائد الوثنيّة في الجن، أنْ يوحي بأنّ القرآن هو كلام النبيّ محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وليس كلام الله، فيقول: (السكينة: كلمةٌ مستعارةٌ من العبريّة(شكينا) ، وهي تدلّ في هذه اللغة على حضرة الله بالمعنى الروحي الخالص، وتتجلّى هذه الحضرة أحياناً بعلامة كنار أو سحابة أو نور ممّا يستطاع إدراكه بالحواس.
ومن الواضح أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لم يتبيّن بجلاء المعنى الحق لهذه الكلمة، إذ يقول: إنّ السكينة هي وبعض الآثار كانت مودعة في تابوت بني إسرائيل المقدّس، ولعلّه قرن هذه الكلمة العبريّة المستعارة بتصوّرات استقاها من العقائد الوثنيّة في الجن)(٤) .
____________________
(١) المصدر ٧: ١٩٥ - ١٩٦.
(٢) في المصحف العثماني رقم الآية ٨٦.
(٣) المصدر ٩: ٣٠١.
(٤) المصدر ١٢: ١٨ - ١٩.
وتحت مادّة(السحر) يرسل(هيك) دعواه بتأثير المسيحيّة واليهوديّة في هذا الدين، إرسال المسلّمات وبصياغة صريحة من أنّه من مؤلّفات هاتين الديانتَين، بالإضافةِ إلى غيرهما ممّا هو سائد في جزيرة العرب آنذاك، فيقول: (وهكذا نجد أنّ عالم الأرواح في جزيرة العرب، مهد الإسلام، على أيّام محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، كان يتألّف - بصرف النظر عن الآثار المسيحيّة واليهوديّة التي في هذا الدين - مِن الله ومن الآلهة القبليّة والجن، وكان الكهّان والسحرة والعرّافون والشعراء والمجذوبون، صلة الوصل بين الناس وبين هذا العالم)(١) .
وتحت مادّة(داود) ومن خلال بحثه عن مصدر معلومات النبيّ محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عن النبيّ داود (عليه السلام) يحاول(كارادي فو) إثبات أنَّ محمّداً استقى قصّة النبيّ داود في قرآنه من التوراة، فيقول: (وقد ورد ذكره [داود] في التوراة.
وفي القرآن عدّة آيات تشير إلى قصّة الملك النبيّ داود، خليفة الله (سورة ص - الآية ٢٥)، وقد حُرّفت هذه القصّة شأن غيرها من قصص الأنبياء بعض التحريف، ويظهر فيها أثر من مذهب الربانيّين، أو قُل: إنّه يبدو فيها أثر السعي إلى تفسير بعض آيات مِن التوراة لم تعرف على وجهها الصحيح، فقد كان محمّد يعلم أنّ داود قتل جالوت (القرآن، سورة البقرة - الآية ٢٥٠ وما بعدها) وأنّ الله آتاه الزبور، والزبور سِفر من الأسفار الأربعة التي عرفها محمّد من التوراة)(٢) .
وتحت مادّة (الجنّة) كما في غيرها من الموادّ المشابهة يكرّس (كارادي فو) دعواه بأنَّ محمّداً أو مَن كان وراءه قد تأثّروا بالمسيحيّة، فيقول: (ولا بدَّ من أنّ يكون محمّد أو معلّموه المجهولون قد رأوا بعض التصاوير أو بعض قطع الفسيفساء المسيحيّة التي تُصوّر حدائق الفردوس، وأوّلوا صورَ الملائكة كما لو كانت صورَ
____________________
(١) المصدر ١١: ٣٠٤.
(٢) المصدر ٩: ١٢١.
الوِلدان والحُور)(١) .
وللإيحاء بدعوى أنَّ النبيّ محمّداً (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قد أخذ من الأديان السابقة وتأثّر بها في صياغة دينه الجديد، يقول (كاستر) تحت مادّة (الأدب السامري): (والتشابه بين أصل الحديث وبين السنّة السامريّة الشفويّة، أوثق من التشابه بين الحديث وبين السنّة اليهوديّة أو المسيحيّة)(٢) .
ويُحاول (جوينبل Th. W. Juynboll ) أنْ يُؤكّد هذه الشبهة فيدّعي أنّ الإقامة أُخذت من اليهود والنصارى، حيث يقول تحت مادّة (إقامة): (إنّ المسلمين استعاروا عبارات الإقامة من البركات التي تُتلى في صلاة اليهود، في حين يقول (بيكر Zur: C. H. Becker, Geschichtedes ص٣، ص٣٨٩ Islamischen Kultuse Der Islam ):
إنّها نشأت مِن الأذان الذي نُسِج على منوال القدّاس عند النصارى)(٣) .
وهكذا يَنساق كتّاب دائرة المعارف الإسلاميّة مع هذه الدعوى، ويردّدون نفس الشبهة في موادّها الأُخرى، منها ما في مادّة (الجمعة) التي يقول فيها (جوينبل): (ويصحّ أنْ نذهب إلى أنّ النبيّ نفسه جرى على إقامةِ صلاةٍ عامّة، وإلقاء خطبة على طريقة اليهود في فناء داره بالمدينة في أيّام الجمعة، ولعلّه قد جرى على إقامة الصلاة تتبعها الخطبة كما كانت عليه الحال لدى الجماعات المُماثلة في الأزمنة السابقة له، إذ كانت الصلاة العامّة تسبق أداء الأعمال الأُخرى)(٤) .
وتحت مادّة(الخطبة) يُحاول (فنسنك A. J Wensinck ) أنْ ينفي الوحي
____________________
(١) المصدر ٧: ١٤٢.
(٢) المصدر ١١: ١٠٧.
(٣) المصدر ٢: ٤٥٥.
(٤) المصدر ٧: ١٠٥.
الإلهي للنبيّ محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وتشريعه لنظام عبادة الصلاة الإسلاميّة فيقول: (ومهما يكن من أمر الشكّ في هذه الأحاديث، فلسنا نبتعد عن القصد إذا ذهبنا إلى أنّ النظام المحدّد للصلاة يوم الجمعة والعيدين، إنّما نشأ بعد وفاة النبيّ. وهذا النظام يعتمد على ثلاثة عناصر: الخطبة الجاهليّة والسنّة، والمُثل المستقاة من اليهود والنصارى.
وقد حاول (بيكر G. H. Becker ) في دراسته لتاريخ العبادات الإسلاميّة أنْ يعقد صلةً وثيقةً بين صلاة الجمعة والعيدَين من ناحية، والقدّاس من ناحية أُخرى والخصائص الأساسيّة لرأيه هي: أنّ الخطبة الأُولى تُطابق الجزء الأوّل من القدّاس ( Vormesse ) والأذان والخطبة صدى للعبادات التي تدور بين الشماس والقسيس الذي يتلو القداس. والتلاوة الواجبة لآيات القرآن تُطابق القراءة من الكتاب المقدّس، وهو يقول عن الخطبتين: إنّ هذه الثنائيّة محل لاختلاف الفقهاء، انتقلت إلى صلاة العيدين عن طريق صلاة الجمعة.
أمّا الخطبة الثانية فتُطابق العِظة والصلاة الجامعة عند النصارى. وقد عارض هذا الرأي (متفوخ Mittwoch ) الذي وجد في القدّاس اليهودي سِمات تُماثل الأذان والإقامة، وتُماثل (الحمدلة) و(التلاوة) من التوراة (الخطبة الأولى) و(التلاوة) من سِفر الأنبياء (الخطبة الثانية). وربّما كان من المستحيل أنْ نأتي بالقول الفصل في هذا الموضوع، ولعلّ المثل المستقى من الشعائر اليهوديّة والمسيحيّة كان ذا تأثير في الهيكل الذي استقرّت عليه الصلاة عند المسلمين)(١) .
ونفس الدعوى تتكرّر في مادّة(صوم) التي كتبها (بيرك G. G. Berg ) كما في المقاطع التالية: (أمّا (الصوم) [بمعنى الإمساك عن الطعام والشراب] فيجوز أنْ يكون مأخوذاً عن الاستعمال اللغوي اليهودي - الآرامي - لِما عَرَف محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)
____________________
(١) المصدر ٨: ٣٧٥ - ٣٧٦.
وهو في المدينة شعيرة الصوم عن كثب)(١) .
ويستمرّ في هذه الدعوى فيقول في موضعٍ آخر من نفس المادّة: (ويدلّ على ظهور الصيام باعتباره رياضةً اختياريّة، غايتها قهر الشهوات بين المسلمين الأوّلين في مكّة ما يغلب على الظن مِن أنّ محمّداً (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وهو في أسفاره الكثيرة، لاحظ هذه العبادة عند اليهود والنصارى)(٢) .
ويقول أيضا في نفس المادّة: (... لكنّ محمّداً (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لم يكن على كلّ حال عارفاً بالتفصيلات؛ لأنه لم يأمر بصوم يوم عاشوراء، إلاّ بعد الهجرة لمّا رأى اليهود يصومونه)(٣) .
ويذهب(بيرك) إلى أكثر من ذلك في ادعائه هذا، فينقل آراء آخرين تحت نفس المادة فيقول: (وفيما يتعلّق بمسألة السبب الذي من أجله اختار محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) شهر رمضان بالذات والمصدر الذي أُخذت عنه شعيرة الصوم الإسلاميّة، قيلت آراء عديدة، ويقول الإسلام: إنّه هو الصوم الذي فرضه الله على اليهود والنصارى لكنّهم أفسدوه، فأعاده محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إلى صورته الصحيحة، ويذهب (سپرنكر Sprenger ) إلى أنّه تقليد لصوم الأربعين عند النصارى، و(نولدكه وشفالي Noldeke – Schwally ) يُشيران إلى مشابهة الصوم الإسلامي لنوع الصوم عند المانويّة)(٤) .
أمّا (فير T. H. Weir ) فيُساهم هو الآخر في طرح هذه الشبهة والإيحاء بأنّ العديد من العبادات التي جاء بها النبيّ محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ما هي إلاّ موروثات
____________________
(١) المصدر ١٤: ٣٩٣ - ٣٩٤.
(٢) المصدر ١٤: ٣٩٥ - ٣٩٦.
(٣) المصدر ١٤: ٣٩٧.
(٤) المصدر ١٤: ٣٩٨ - ٣٩٩.
متأصّلة لدى العرب زمن الجاهليّة حيث يقول تحت مادّة(الجاهليّة): (... ولكنّه [محمّداً (صلّى الله عليه وآله وسلّم)] وجد الحجّ إلى الأماكن المقدّسة متأصّلاً في نفوس العرب لا يستطيع له دفعاً. وكان قصاراه أَلاّ يُبقي من بيوت العبادة إلاّ على بيتٍ واحد، جعله بيت الله الواحد)(١) .
ويقول (فنسنك Wensinck ) في نفس الاتّجاه تحت مادّة (أصل الحجّ في الإسلام): (لم تكن نظرة النبيّ إلى الحجّ واحدة على الدوام، فلابدّ أنّه اشترك كثيراً في مناسكه وهو حدث، أمّا بعد دعوته فقد كانت عنايته قليلة أوّل الأمر بالحج، فلم يرد ذكر الحجّ في السور القديمة، ولا يبدو من المصادر الأُخرى أنّ النبيّ اتّخذ خطّة محدّدة حيال هذه العادة الوثنيّة الأصل)(٢) .
ويفصّل(فنسنك) أكثر في دعمه لهذه الشبهة، فيقول تحت نفس المادّة: (إنّ الوقوف في سهل عرفات من أهمّ مناسك الحجّ، فالحجّ بدون الوقوف باطل في الإسلام، وإنّما يُفسّر هذا الأمر بأنّه أثر لفكرة جاهليّة، وقد وازن (هوتسما Houtsma ) بين الوقوف وبين إقامة بني إسرائيل على جبل سينا، فهؤلاء يعدّون أنفسهم لهذه الإقامة بالامتناع عن النساء وبغسل ثيابهم، وبذلك يقفون أمام الرب، وعلى هذا النحو لا يقرب المسلمون النساء ويرتدون ثياب الإحرام ويقفون أمام الخالق في سفْح جبلٍ مقدّس)(٣) .
وينساق (فنسنك) تحت مادّة (إحرام) مع هذه الدعوى قائلاً: (ونلاحظ أنّ ثوب الإحرام ربّما كان الثوب المقدّس عند قدماء الساميّين، إذْ إنَّ الجزء الأعلى من الثوب الذي كان يرتديه الكاهن الأعظم في (العهد القديم) كان غير مخيط..
____________________
(١) المصدر ٦: ٢٦٧.
(٢) المصدر ٧: ٣٠١.
(٣) المصدر ٧: ٣٠٦.
ويرتدي كهنة اليهود الأفود (الصُّدرة) حول الحرقفتين والمَيل حول الكتفين.
ونجد لهذا نظيراً في الإسلام عند الصلاة وفي تكفين الميّت، وكان العرب في جاهليّتهم عند الكهانة يلبسون رداءً ومِئزراً، كما كان الزهّاد المتأخّرون يرتدون مثل هذا الثوب. يُضاف إلى ذلك أنّ اللون الأبيض يُعدُّ مقدّساً في كثير من الأديان... فلباس الإحرام والحالة هذه قديم جدّاً ولا يرجع أصله للإسلام. زد على ذلك أنّ لبس الحِذاء محرمٌ كذلك... وهذه عادة ساميّة قديمة كذلك... ويجب كذلك على المُحرِم أنْ لا يُغطّي رأسه، وربما كانت هذه عادة من عادات الحزن قبل الإسلام)(١) .
وينقل (فنسنك) رأي(سنوك هجروينيه) في هذا الموضوع، الذي صوّر هذه الشبهة مرّةً بأنّها نظريّات يراها النبيّ محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ليَتفادى بها الصورة القاسية، التي كانت تُمارَس بها هذه العبادات في الجاهليّة، ومرّةً أُخرى يصوّرها بأنّها ممارسات مشتملة على قذارات كانت على عهد الجاهليّة، ومنها ما كان على عهد الديانات الساميّة أيضاً، كاليهود فيقول في مادّة(إحرام): (إنّ محرّمات الإحرام قد غدت قاسيةً في نظر النبيّ، لذلك نجده أثناء مكثه في مكّة قبل الحجّ يتحلّل من هذه المحرّمات،...
وعلى ذلك فإنّ ما تراءى للنبيّ ومعاصريه أنّه إهمال يستوجب التكفير قد غدا في نظر الأجيال اللاحقة أمراً مُباحاً... وقد منع الشرع المُحْرِم من جملة أُمور: النكاح والتطيّب وإراقة الدم والصيد، كما حرّم اقتلاع النبات. ونلاحظ بهذه المناسبة أنّ بعض الأديان الساميّة يُحرّم النكاح في حالات أُخرى، ونخصّ بالذكر من هذه الأديان ما يقول بالتوحيد. وكان إهمال العناية بالبدن ظاهرةً معروفة بين الشعوب الساميّة في الأحوال الدينيّة، وتُصوّر لنا الروايات أنّ
____________________
(١) المصدر ١: ٤٤٤ - ٤٤٥.
النادبات في الجاهليّة كنّ قذِرات ذوات شعرٍ أشعث، ويمتنع اليهود مدّة حدادهم عن الاستحمام وتقليم الأظافر. ويذكرون أنّ الحجّاج في الجاهليّة وفي عصر النبيّ كانوا يضمّخون شعورهم وقت الإحرام تخفيفاً لوطأة القذارة)(١) .
كما ويصرّح (بول Fr. Buhl ) بالشبهة دون تردّد، فيقول تحت مادّة(الجمرة) : (ورمي الجمرات شعيرة أخذها الإسلام عن الوثنية فلم ينصّ عليها صراحة في القرآن، ولكنّها ذكرت في سير النبيّ وفي الحديث)(٢) .
ويسلك (شاخت Josephj Schacht ) نفس نهج أضرابه فيقول تحت مادّة (زكاة): (إنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) استعملها بمعنىً أوسع من ذلك بكثير، أخذاً عن استعمالها عند اليهود (في اليهوديّة - الآراميّة: زاكوت)... ولمّا كان النبيّ محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قد عرّف التقوى من هذا الوجه، على أنّها من مميّزات الأديان المنزَّلة، فإنّه من أوّل الأمر قد اعتبر البرّ من الفضائل الكبرى التي يتحلّى بها المؤمن الحقّ (انظر سورة الرعد، آية ٢٢، سورة فاطر، آية ٢٩)(٣) .
ويضيف(شاخت) قائلاً: (وترد كلمة صدَقة مرادفة لكلمة زكاة تقريباً، ولا ريب أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قد عرَف ذلك من يهود المدينة معرفةً أدق. ولم يلبث معنى الزكاة أنْ تأثّر في المدينة أيضاً بتغيّر الأحوال)(٤) .
وينقلشاخت حديثه إلى مادّة (زنى) ليردّد نفس الشبهة فيقول: (أمّا في القرآن فقد جاء النهي عن الزنا، وأنّ العفّة من صفات المؤمنين، ويظهر أنّ ذلك كان
____________________
(١) راجع: المصدر ١: ٤٤٤ - ٤٤٥.
(٢) المصدر ٧: ١٠٣.
(٣) المصدر ١٠: ٣٥٦.
(٤) المصدر ١٠: ٣٥٧.
تحت تأثير اليهوديّة أو النصرانيّة)(١) .
أمّا(هفننج Heffening ) فيردّد نفس الشبهة في مادّة (التجارة) فيقول: (لكن محمّداً قد رفع في الوقت نفسه صوته محذّراً من الشرور التي بدأت تقترن بالتجارة، فقال: إنّ التجارة ينبغي أنْ تكون على مقتضى الشرع والعدل. وقد جاء في سورة المُطَفِّفِينَ: ( وَيْلٌ لِلْمُطَفّفِينَ *الّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النّاسِ يَسْتَوْفُونَ *وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ) ، (انظر سورة الرحمن، الآيات(٧) إلى(٩) ، ومن العهد المكّي الثالث سورة الأنعام، الآية(١٥٢) ، سورة الأعراف الآية٨٤ ).
وقد تغيّرت نظرة النبيّ بعد ذلك تغيّراً معيّناً يجب أنْ نردّه إلى العهد المكّي، ولو أنّه ليس في القرآن شواهد على ذلك إلاّ في سور العهد المدني، إذ تحوّلت نظرته إلى التجارة بفعلِ آراء الزهّاد من النصارى. وهو لم يحرّمها، وإنّما رأى فيها ما قد يعوق المؤمنين عن عبادة الله، ويصرفهم عن الصلاة، ويظهر هذا بأجلى بيان في وصف الأديار الذي ورد في سورة النور المدنيّة الآية(٣٧) : ( رِجَالٌ لاّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللّهِ... ) ، ومهما يكن من شيء فإنّ المحصّل مِن هذه الآية أنّ النبيّ كان يدرك إدراكاً تامّاً للتجارة من آثار سيّئة في الحياة الدينيّة. وكان من نتيجة تسلسل هذه الأفكار أنّ التجارة حرّمت في السور المدنيّة تحريماً باتّاًإذا نُوديَ للصلاة من يوم الجمعة. وشاهد ذلك سورة الجمعة، الآيات من(٩) إلى(١١) . ومن جهةٍ أُخرى أحلّ الرسول في أواخر العهد المدني البيع إبان الحج (سورة البقرة، آية٣٩٧ )(٢)(٣) .
ويُساهم(هـ. هـ. بروى H. H. pau ) أيضاً في ترديد هذه الشبهة فيقول
____________________
(١) المصدر ١٠: ٤١١.
(٢) وقد ورد رقم الآية في دائرة المعارف الإسلاميّة خطأً، والصحيح ١٩٨.
(٣) المصدر ٤: ٥٨٢.
تحت مادّة(أُميّة بن أبي الصلت) : (والآراء الدينيّة في كلام أُميّة مطابقة لما جاء في القرآن إلى حدٍّ كبير، ويكاد الاتّفاق يقع كلمةً كلمة في كثير من الأقوال، ولهذا أُثيرت بالطبع مسألة اعتماد أحد القولين على الآخر. فيذهب(هيوار) إلى أنّ أشعار أُميّة بن أبي الصلت - التي تتضمّن قصصاً من قصص التوراة مذكورة عند المقدسي في (كتاب البدء)، وهو الكتاب الذي نُسبَ خطأ إلى البلخي - هي من المصادر الصحيحة التي استمدَّ منها القرآن رأساً)(١) .
ويضيف أيضاً في نفس المادّة: (... ويُمكن أنْ نعلّل مشابهة قصائد أُميّة لما جاء في القرآن بحقيقة لا تَحتمل شكّاً هي: أنّه في أيّام البعثة المحمّديّة، وقبلها بقليل من الزمان، انتشرت نزعات فكريّة شبيهةً بآراء الحنيفيّة، واستهوت الكثيرين من أهل الحضر، وخصوصاً في مكّة والطائف، وكانت تُغذّيها وتنشّطها تفاسير اليهود للتوراة، وأساطير المسيحيّين، ممّا كان معروفاً ومتداولاً في تلك البقاع وجنوبي الجزيرة في جهات متفرّقة منعزلة... ومحمّد وأُميّة وغيرهما من الرجال المتديّنين، كزيد بن عمرو وورقة ومسلمة، اقتبسوا جميعاً من مصادر واحدة، سَواء أكانت مدوّنة كما يرى( Schulthess ) أم مرويّة كما يذهب إليه( Noldeke ) (٢) .
هذه خلاصة لأهمّ موارد الدسّ والتشويه الاستشراقي، تستهدف تكوين الشبهة المدّعاة، بأنّ محمّداً (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، تأثّر واستقى من اليهوديّة والنصرانيّة أو الجاهليّة، في صياغة آيات قرآنه ومفردات وأحكام دينه الجديد، وهي في مُجملها تحاول اختلاق وصياغة شبهة أساسيّة طالما بذلوا جهدهم لدعمها وتأكيدها، وهي أفكار الوحي الإلهي للنبيّ محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وأنّ ما جاء به لا يعدو أنْ يكون تلفيقاً بين ما اقتبسه من اليهود والنصارى، ومن مفردات ومؤثّرات بيئته الجاهليّة آنذاك.
____________________
(١) المصدر ٢: ٦٦٠ - ٦٦٢.
(٢) المصدر ٢: ٦٦١ - ٦٦٢.
ونكتفي في هذه الفقرة ببيان الردّ والعلاج للمفردات التفصيليّة لموارد الدسّ والتشويه هذه، مُحيلين أمر الرد على أصل شبهة إنكار الوحي الإلهي للنبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إلى بحثٍ مستقلٍّ سيأتي في فصلٍ قادم إنْ شاء الله:
١ - قول(كارادي فو) تحت مادّة(جبريل) : فيه انسياقٌ واضح مع إنكار الوحي الإلهي للرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، ويشهد لذلك أيضاً تعبيره عن الآية ١٩ من سورة مريم في آخر قوله المذكور أعلاه، بأنّها رأي النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وليس قول الله في قرآنه الكريم.
وجوابه نحيله إلى محلّه، على أنّه لم يأتِ لنا بدليلٍ أو حتّى شاهدٍ أو قرينةٍ على استظهاره أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عرف جبريل من خَبر البشارة الوارد في الإنجيل، ولا على احتماله سماعه ذلك الخبر من أفواه بعض الفلاسفة أو الباحثين في الأديان، وغير ذلك من الاحتمالات، فأيّ قيمةٍ لهذا الاستظهار وتلك الاحتمالات؟
٢ - قول(هيك) تحت مادّة(سحر): وأمر هذين القولين كسابقهما، وهنا لم يسُق إلينا القائل دليلاً واحداً ولا شاهداً على مدّعاه. إلاّ أنّه لا يعدم وجود تقارب والتقاء في بعض المفاهيم والعقائد والأحكام والإسلاميّة مع الأديان السابقة كالمسيحيّة واليهوديّة؛ لأنّ الإسلام لا ينكر تلك الأديان، ولا ينكر الرسُل الذين أرسلهم الله سبحانه بها، ولا الكتب المنزّلة من لدنه تعالى عليهم، كالتوراة والإنجيل، بل يصرّح بأنّه خاتم الأديان وأكملها، وأنّ القرآن المجيد خاتم الكتب، والرسول الكريم (صلّى الله عليه وآله وسلّم) خاتم الأنبياء وأكملهم، إلاّ أنّه يعتقد بأنّ يد التحريف قد طالت هذه الأديان والكتب، كما يعتقد أنّ النسخ حصل للعديد من الأحكام التشريعيّة(١) الواردة فيها، وما تبقّى من الصحيح وغير المنسوخ منها يُقارب
____________________
(١) لأنّ النسخ ينحصر أمره بالأحكام التشريعيّة دون العقائد والوقائع، إنّما الذي يحصل في الأخيرين هو الإجمال أو التفصيل، والبيان لمفرداتها بما يتناسب وتطوّر الإدراك والفكر البشري والمناسبات الموضوعيّة لها.
ويلتقى عادة مع ما جاء به الإسلام؛ لأنّه من سراجٍ ومصدرٍ واحد.
٣ - قول(ر. پاريه) تحت مادّة(أمّة)، وقول(كارادي فو) تحت مادّة(جهنّم) وتحت مادّة(دنيا)، وقول(جويل) تحت مادّة(السكينة) : فيه أنّ طريقة الاستدلال على كون كلمة(أُمّة) وأمثالها من الكلمات المذكورة في أقوال الآخرين دخيلةٌ ومأخوذةٌ من العبريّة، مثلاً لمجرد وجود شبَه لفظي في حرف أو حرفين بين الكلمة العربيّة وكلمة بمعناها في العبريّة متكلّفة لا تخلو من تمحّل ومغالطة، إذ بهذه الطريقة سوف نهدم الكثير من صِيغ الوضع اللفظي للّغات، إلاّ إذا ساق المدّعي دليلاً أو قرينةً معتبرةً على مدّعاه.
ويُمكن ردّ هذا الادّعاء أيضاً بقولنا: إنّ كلمة(أُمّة) لها معانٍ متعدّدة في اللغة العربيّة،منها:
الشِّرعة والدين، القَرْن من الناس، الرجل لا نظير له، الحين، وقد وردت هذه الكلمة في هذه المعاني في الشعر العربي الجاهلي، منه قول النابغة الذبياني:
حلفتُ فلم أترك لنفسك ريبة * وهل يأثمن ذو أُمّة وهو طائع
ويريد بها هنا أهل الدين والشرعة.
ومنها أيضاً قول الشاعر:
وهل يستوي ذو أُمّة وكفور
أي ذو دين وذو نحلة(١) .
كما أنّه لو كانت هذه الكلمة دخيلة من العبريّة لاستقلّت بمعناها المدّعى في العبريّة، وهو شعبٌ أو جماعة، على أنّ هناك قولاً بأنّ اللغة العربيّة أسبق وجوداً في الجزيرة العربيّة من العبريّة. ولو سلّمنا وصحّ هذا الادّعاء فلا يثبت منه قول
____________________
(١) راجع ترتيب كتاب العين للخليل، ومعه الدليل إلى المستعملات في اللغة العربيّة: أُمم، ولسان العرب ١٢: أُمم.
(پاريه): (فإنّ محمّداً أخذ هذه الكلمة واستعملها، وصارت منذ ذلك الحين لفظاً إسلاميّاً أصيلاً)إذ إنّها - حسب الدعوى - قد أصبحت جزءاً من اللغة العربيّة واستعمالها في المراد المعنوي لها سواء في القرآن الكريم أو في السنّة الشريفة استعمال مألوف وليس قائماً على قصد الاستقاء من العبريّة، هذا مضافاً إلى أنّ القرآن الكريم كلام الله عزّ وجل وليس كلام الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إلاّ إذا أنكر(پاريه) ذلك، فعندها يأتي كلامنا الآنف إنْ شاء الله في صدق الوحي الإلهي للرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم).
٤ - قول(كاستر) تحت مادّة (السامرة) عليه نفس ما أوردناه على قول(هيك) السالف تحت مادّة(سحر)، ونضيف إليه ردّاً على قوله: (قال أبو الفتح...) أنّ اليهودي (كعب الأحبار) المشهور لم يرَ النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قط، ولم يأتِ المدينة إلاّ بعد وفاته (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وأنّه أسلم وقدِم إلى المدينة في عهدِ أبي بكرٍ أو عُمر، كما هو ثابت في تاريخنا الإسلامي(١) .
وأمّا النصراني الذي يُسمّيه(آب سمليه) فلا نعرف من هو، ولم تذكر لنا كتب التاريخ شخصاً بهذا الاسم، على أن الثالث وهو السامري مُنكرٌ تماماً، إذ لم يذكر لنا اسمه ولا علامة عليه، رغم ادّعائه أنّه استطاع أنْ يؤثّر في النبيّ أكثر من صاحبيه.
٥ - قول(ليفي دلافيدا) تحت مادّة (تميم الداري) فيه إضافة إلى ما سبق منّا أنْ تميماً الداري هذا لم ينقل لنا التاريخ أنّه التقى برسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قبل بعثته وبعدها حتّى إسلامه، ولهذا تجد عبارة(ليفي دلافيدا) مجملة بأنّ تميماً كان نصرانيّاً كغالِب عرَب الشام، ثمّ يفرّع عليه إخباره للرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم). ثمّ إنّه كان قد أسلم في السنة التاسعة بعد الهجرة، أي بعد أنْ نزلت أغلب آيات القرآن الكريم، وعلّم النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) المسلمين أغلَب أحكام الشريعة الإسلاميّة، سواء في العبادات أو المعاملات،
____________________
(١) راجع تاريخ الطبري ٥: ٦٧ والغدير للأميني ٨: ٣٦٥ ومعالم المدرستين للعسكري ٢: ٥١.
بحيث استوثقت معالم الدين وبانت ملامحه التفصيليّة، خصوصاً في الجانب العبادي منه الذي كان بيان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لأغلب مفرداته أسبق من بيانه لمفردات جانب المعاملات، فما الذي بقيَ منها ليقوم تميم الداري بإخبار النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) به، لتتم الاستعارة المدّعاة لتفاصيل العبادات من النصارى؟ على أنّنا كما قلنا سلفاً لا يعدم وجود نوع من التشابه في بعضها من التي لم تُحرّف من الديانات السماويّة السالفة، ولم يطلْها النسخ الذي سِيق منّا بيانٌ مختصرٌ عن حقيقته.
٦ - قول(هورفتر) تحت مادّة(التوراة) وقول(كارادي فو) تحت مادّة(داود) وتحت مادّة(الجنّة) فيه نفس ما أوردناه على قول(هيك) السالف تحت مادّة(سحر) فراجع، مضافاً إلى أنّ عبارتيهما تشيران إلى أنّ الأصل - في عقيدتهما - هو ما ورد في التوراة، وهو الصحيح الذي لا تحريف فيه، وأنّ محمّداً (صلّى الله عليه وآله وسلّم) هو الذي حرّف بعضه ليُلائم أغراضه الخاصّة، ويقصد من ذلك أنّ القرآن من صُنع محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأنّه حرّف ما في التوراة ليُميّز دعوته ويُظهرها بثوبٍ جديد.
والكلام نفسه يرد على قوله تحت مادّة(الجنّة): (ولابدّ من أنْ يكون محمّد ومعلّموه المجهولون...) على أنّه لم يسُق أدنى دليل أو قرينة على أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كان قد رأى كنائس ليُشاهد فيها مثل هذه الصور، أو أنّ له معلّمين مجهولين، إذ ليس في مثل هذه الأقوال إلاّ التمحّل والتعبير عن الخلفيّة المتعصّبة بهذه الافتراءات.
وهكذا يرد على قول(كاستر) تحت مادّة (الأدب السامري): (التشابه بين أصل الحديث وبين السنّة السامريّة الشفوية...) إلى آخره، فكلّها دعاوى جزافيّة لا وزن لها في معايير البحث العلمي.
٧ - قول(جوينبل) تحت مادّة(إقامة): (إنّ المسلمين استعاروا عبارات الإقامة من البركات التي تُتلى في صلاة اليهود) وكذلك وجه الشبهة بين الأذان
والقدّاس عند النصارى، لتترتب عليهما دعوى الاستعارة والنسج الواحد، فيه أنّ الثابت فيما ورد عن أهل البيت (عليهم السلام) أنّ الإقامة والأذان وحيٌ إلهي لرسوله الكريم (صلّى الله عليه وآله وسلّم).
فقد روى محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمير، عن عُمر بن أُذينة، عن زرارة أو الفضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
(لمّا أُسريَ برسولِ الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إلى السماء فبلغ البيت المعمور، وحضرت الصلاة فأذّن جبرئيل وأقام، فتقدّم رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وصَفَّ الملائكة والنبيّون خلف محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)) (١) .
وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عُمير، عن حمّاد، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
(لمّا هبط جبرئيل (عليه السلام) بالأذان على رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، كان رأسه في حِجْر عليّ (عليه السلام) فأذّن جبرئيل وأقام، فلمّا انتبه رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال: يا عليّ، سمعت؟ قال: نعم، قال: حفظت؟ قال: نعم، قال: ادعُ لي بِلالاً فعلّمه، فدعا عليّ (عليه السلام) بلالاً فعلّمه) .
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم، ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(٢) .
وفي معرض استنكار الإمام الصادق (عليه السلام)، ولعنه لمن يدّعي أنّه أخذ الأذان عن غير طريق الوحي الإلهي، نقل محمّد بن مكّي الشهيد في(الذكرى) عن ابن أبي عقيل عن الصادق (عليه السلام): أنّه لعن قوماً زعموا أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أخذ الأذان من عبد الله بن زيد، فقال (ينزل الوحي على نبيّكم فتزعمون أنّه أخذ الأذان من عبد الله بن زيد؟!)(٣) . على أنّ لازم كلامهما السالف هو إنكار الوحي الإلهي لرسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وردّنا عليه في محلّه إنْ شاء الله.
____________________
(١) وسائل الشيعة ٤: (أبواب الأذان والإقامة) ح٦٨١٤.
(٢) وسائل الشيعة ٤: (أبواب الأذان والإقامة) ح ٦٨١٥.
(٣) وسائل الشيعة ٤: (أبواب الأذان والإقامة) ح٦٨١٦.
أمّا قوله تحت مادّة(الجمعة) : (ويصحّ أنْ نذهب إلى أنّ النبيّ نفسه جرى على إقامة صلاة عامّة، وإلقاء خطبة على طريقة اليهود..) إلى آخره، فإضافةً إلى ما فيه من إيحاء بإنكار الوحي لرسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، فيه أيضاً أنّ افتراض وجود تشابهٍ ما، في كلّيّات عبادة معيّنة في مفرداتها الكثير من الاختلافات التفصيليّة، شكلاً ومضموناً لا تنهض دليلاً، بل ولا حتّى قرينةً على وحدة الطريقة في تلك العبادة، فكيف يُفرّع عليها تبعيّة إحداهما للأخرى؟
ثُمّ إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كان يُقيم صلاة الجمعة في المسجد لا في فناء داره، لعدم وجود مثل هذا الفناء أساساً، كما هو ثابت تاريخيّاً، ولعلّ(جوينبل) هذا توهّم أنّ المسجد هو فناء دار رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)؛ لأنّ بيوت الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأهل بيته الطاهرين (عليهم السلام) كانت متّصلة ومُلحقة بالمسجد، ولها أبواب خاصّة توصلها به.
أمّا قوله: (... ولعلّه [الرسول] قد جرى على إقامة الصلاة تتبعها الخطبة...) إلى آخره، فهو قول لا صحّة له؛ لأنّ الروايات بلغت شهرةً عظيمة عن الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأهل بيته الطاهرين (عليهم السلام)، وما عليه سيرة المتشرّعة من عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إلى يومنا هذا، في أنّ صلاة الجمعة تبدأ بخطبتين يجلس بينهما الخطيب جلسةً خفيفةً ثُمّ يصلّي ركعتَي صلاة الجمعة، ولم يُروَ قط أن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بدأ بصلاة الجمعة قبل الخطبة، وعلى هذا انعقد إجماع فقهاء المسلمين على اختلاف مذاهبهم.
وممّا روي في ذلك ما عن محمّد بن الحسين بإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن عثمان بن عيسى عن أبي مريَم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن خطبة رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أَقَبْلَ الصلاة أو بعدها؟
قال:(قَبْل الصلاة ثمّ يُصلّي) .
وروى الكليني عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليّ بن مهزيار مثله، إلاّ أنّه قال:
(يَخطب ثُمّ يصلّي) (١) .
وقال صاحب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام في وقت الخطبة من صلاة الجمعة ما نصّه:
والمشهور نقلاً وتحصيلاً أنّه يجب أنْ تكون الخطبة مقدّمة على الصلاة شهرةً عظيمةً لا بأس بدعوى الإجماع معها، بل في كشف اللثام استظهار دعواه، كما في المحكي عن المنتهى نفي العلم بالمخالف فيه، بل عن مجمع البرهان نفي الخلاف للسيرة القطعيّة، والتأسّي بفعل الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) المعلوم بالنصوص، والسيرة القطعيّة على وجهٍ يقتضي الوجوب... إلى آخر قوله(٢) .
أمّا قول(فنسنك) تحت مادّة(خطبة): (إنّ النظام المحدّد للصلاة يوم الجمعة والعيدين إنّما نشأ بعد وفاة النبيّ)، (وهذا النظام يعتمد على ثلاثة عناصر: الخطبة الجاهليّة، والسنّة، والمُثُل المستقاة من اليهود والنصارى)، وما نقله عن(بيكر) و(متفوخ) تحت نفس المادّة، يرد عليه ما أوردناه أعلاه على قول(جوينبل) تحت مادّتَي (إقامة) و(الجمعة).
ويضاف إليه أنّ ادّعاء(فنسنك) الصلة الوثيقة بين صلاة الجمعة والعيدين من ناحية، والقدّاس من ناحية أُخرى غريب، إذ لا وجه للتشابه بينهما لا شكلاً ولا مضموناً، فكيف تدّعى الصلة الوثيقة؟ فالقدّاس عند النصارى هو ذبيحة جسد ودم السيّد المسيح، يُقدَّمان على الهيكل تحت شكلَي الخبز والخمر للمصلّين بواسطة القسّيس، ويُعاونه الشماس ضِمن طقوس وتلاوات تدور بين القسّيس والشماس من الكتاب المقدّس(٣) ، فأين هذا من خطبَتَي صلاة الجمعة والعيدين اللتين يجلس بينهما الخطيب جلسةً خفيفة، ثمّ يُصلّي ركعتَي صلاة الجمعة أو العيدين بالمأمومين؟
٨ - قول(بيرك) تحت مادّة(صوم): (أمّا الصوم، بمعنى الإمساك عن
____________________
(١) وسائل الشيعة ٥: باب وجوب تقديم الخطبتين على صلاة الجمعة، ح٩٥١٠.
(٢) جواهر الكلام ١١: كتاب الصلاة: ٢٢٨.
(٣) المنجد في اللغة، مادّة (قدس).
الطعام والشراب، فيجوز أنْ يكون مأخوذاً عن الاستعمال اللغوي اليهودي...) إلى آخره، يرد عليه ما أوردناه على قول(ر. پاريه) تحت مادّة(أُمّة). وما أوردناه على قول(هيك) تحت مادّة(سحر).
أمّا قوله تحت نفس المادّة: (... لكنّ محمّداً (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لم يكن على كلّ حال عارفاً بالتفصيلات؛ لأنّه لم يأمر بصوم يوم عاشوراء، إلاّ بعد الهجرة، لمّا رأى اليهود يصومونه) ففيه:
أ - إنّ عاشوراء على وزن فاعولاء، مختومة بالألف الممدودة، وتصحّ بالألف المقصورة بلا همزة: عاشورا(١) ، فهي صفةٌ مؤنّثة لليلة العاشر من الشهر القمري العربي، وغلب إطلاقها على الليلة العاشرة من أوّل تلك الشهور وهو محرّم الحرام، ولا يُوصف بها اليوم، فلا يُقال: اليوم العاشوراء.
وقد اشتهر استعمال هذه الكلمة في ليلة العاشر من محرّم الحرام، ذكرى شهادة الإمام الثالث من أئمّة أهل بيت النبوّة الطاهرة (عليهم السلام) الحسين بن عليّ (عليهما السلام). مع العلم أن اللغويين قد نصّوا على أنّ هذه الكلمة(اسم إسلامي) (٢) (لم يُعرف في الجاهليّة)(٣) . وعلى هذا فمن أين جاءت دعوى وجود يوم باسم يوم عاشوراء لدى اليهود وأنّهم كانوا يصومونه؟
ب - لعلّ دعوى(بيرك) بوجود مثل هذا اليوم لدى اليهود، وأنّهم كانوا يصومونه، قد استندت على بعض الروايات الضعيفة سنداً، والمتناقضة دلالةً والتي وردت في بعض كتب الحديث، وأدناه نستعرض مجموعتين منها مع الإشارة الكلّيّة إلى ظروف وملابَسات اختلاف هذه الأحاديث ونسبتها كذِباً إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم):
____________________
(١) مجمع البحرين، مادّة (عشر).
(٢) النهاية في غريب الحديث والأثر ٣: ٢٤٠.
(٣) الجمهرة في لغة العرب ٤: ٢١٢.
المجموعة الأولى:
١ - عن عائشة قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهليّة، وكان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يصومه في الجاهليّة، فلمّا قدِم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلمّا فُرِض رمضان ترك يوم عاشوراء فمَن شاء صامه ومَن شاء تركه(١) .
٢ - عنها قالت: كان يوم عاشوراء فكان مَن شاء صامه ومَن شاء لم يَصمه(٢) .
٣ - عنها قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أنْ يُفرَض رمضان، وكان يوماً تسترّ فيه الكعبة، فلمّا فرض الله رمضان قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم):(مَن شاء أنْ يَصومه فليَصُمه، ومَن شاء أنْ يَتركه فليتركه) (٣) .
فكيف التوفيق بين هذا وبين ما مرّ من نصوص اللغويّين، على أنّ اسم عاشوراء اسم إسلامي لم يُعرف في الجاهليّة؟ وإذا كانوا يصومونه؛ لأنّه كان يوماً تُسترّ فيه الكعبة، فلماذا أُضيف إلى وصف الليلة (عاشوراء) كما مرّ؟ ولم تكن الكعبة تُسترّ في الليل طبعاً قطعاً. وهل وصفوا اليوم المُذكّر بصفة التأنيث؟ فالعجب من العرب كيف غاب عنهم هذا؟!
وهنا نتساءل:
بما أنّ الجاهليّة هي عهد ما قبل الإسلام، فإذا كان النبيّ يصوم يوم عاشوراء في الجاهليّة فلماذا تركه بعد الإسلام؟ فلو كان تركه لمخالفة المشركينّ
____________________
(١) صحيح البخاري، كتاب الصوم.
(٢) صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن، سورة البقرة.
(٣) صحيح البخاري، كتاب الحج، الباب ٤٧.
فلماذا رجع إليه بعد الهجرة؟
المجموعة الثانية:
١ - عن ابن عبّاس قال: قدِم النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال:(ما هذا؟) قالوا: هذا يوم صالح، يوم نجّى الله بني إسرائيل من عدوّهم فصامه موسى. قال:(أنا أحقُّ بموسى منكم) فصامه وأمر بصيامه(١) .
٢ - عنه قال: إنّ النبيّ لما قدِم المدينة وجدهم يصومون يوماً (يعني يوم عاشوراء) فقالوا: هذا يومٌ عظيم، وهو يوم نجّى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون، فصام موسى شاكراً لله. فقال:(أنا أولى بِموسى مِنهُم). فصامه وأمر بصيامه.(٢)
٣ - عنه قال: لمّا قدم النبيّ المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسُئلوا عن ذلك فقالوا: هذا هو اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، ونحن نصومه تعظيماً له. فقال رسول الله: ونحن أولى بموسى منكم. فأمر بصومه(٣) .
٤ - عنه قال: قدِم النبيّ المدينة واليهود تصوم عاشوراء فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النبيّ لأصحابه:(أنتم أحقّ بموسى منهم، فصوموا) (٤) .
٥ - عنه قال: لمّا قدِم رسول الله المدينة واليهود تصوم عاشوراء، فسألهم، فقالوا: هذا اليوم الذي ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النبيّ:(نحن أولى بموسى
____________________
(١) صحيح البخاري، كتاب الصوم: ٣٠.
(٢) صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: ٦٠.
(٣) صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، الباب ٥٢.
(٤) صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، سورة يونس.
منهم) (١) .
٦ - عن أبي موسى الأشعري قال: دخل النبيّ المدينة وإذا أُناسٌ من اليهود يعظّمون عاشوراء ويصومونه فقال النبيّ:(نحن أحقّ بصومه)، فأمر بصومه(٢) .
٧ - عنه قال: كان يوم عاشوراء تعدّه اليهود عيداً، فقال النبيّ: فصوموه أنتم(٣) .
وهذه المرويّات عن ابن عبّاس وأبي موسى الأشعري لا نجد فيها أن اليهود كانوا يسمونه عاشوراء، أمّا ما هي حقيقته عند اليهود؟ فهذا ما تبينه لنا دائرة المعارف البريطانيّة بالانجليزيّة والفرنسيّة والألمانيّة حيثُ جاء فيها:
إنّ احتفال اليهود بنجاة موسى وبني إسرائيل يمتدّ سبعة أيّام لا يوماً واحداً فقط.
أمّا صوم اليهود فهو في اليوم العاشر، ولكنّه ليس العاشر من المحرّم، بل من شهرهم الأوّل: تشري، ويسمّونه يوم(كيپور) ، أي يوم(الكفّارة) ، وهو اليوم الذي تلقّى فيه الإسرائيليّون اللوح الثاني مِن ألواح الشريعة العشرة، ولم يكن ذلك يوم نجاتهم من فرعون، بل بعد نجاتهم من فرعون، وميقات موسى (عليه السلام) وابتلائهم بعبادة العجل إلهاً لهم، ورجوع موسى من الميقات إليهم، وإعلان اشتراط قبول توبتهم بقتل بعضهم لبعض، وبحصولهم على العفو من رفقائهم، ولذلك فقد خُصّص اليوم قبل(كيپور) بتبادل العفو فيما بينهم، وخُصّص يوم(كيپور) للصيام والصلاة والتأمّل كأقدس أيّام اليهود.
والتقويم اليهودي المستعمل اليوم عندهم شهوره قمريّة، ولذلك فعدد أيّام
____________________
(١) صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، سورة يونس.
(٢) صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، الباب ٥٢.
(٣) صحيح البخاري، كتاب الصوم: ٣٠.
السنة في السنوات العاديّة ٣٥٥ أو ٣٥٤ أو ٣٥٣، ولكنّهم جعلوا سنواتهم شمسيّة بشهور قمريّة، ولذلك فلهم سنوات كبيسة، ففي كلّ سنةٍ كبيسة يُضاف شهر بعد آذار الشهر السادس باسم آذار الثاني فيكون الشهر السابع، ويكون نيسان الشهر الثامن، وعليه تكون أيّام السنة الكبيسة ٣٨٥ أو ٣٨٤ أو ٣٨٣.
مناقشة ما ورد في روايات المجموعتين:
أ - يلاحظ بخصوص خبرَي أبي موسى الأشعري:
أنّه في الأوّل يقول: (وإذا أُناس من اليهود يعظّمون عاشوراء ويصومونه، فقال النبيّ:(نحن أحقّ بصومه) . فأمر بصومه) بلا ذكر لوجه تعظيمهم ليوم عاشوراء وصومه، ولا ذكر لوجه أحقيّة المسلمين بصومه.
وفي الثاني يقول: (كان يوم عاشوراء تعدّه اليهود عيداً. قال النبيّ:فصوموه أنتم) بلا ذكر لوجه كون يوم عاشوراء عيداً عندهم، ولا ذكر لوجه أمره (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بصومه، وكأنّه يُقابل بين الأمرين: بين صوم المسلمين فيه وعدّه اليهود عيداً، دون الأولويّة.
ب - يلاحظ في الخبَرَين أيضاً:
أنّه قال في الأوّل: (وإذا أُناسٌ من اليهود يعظّمون عاشوراء) وقال في الثاني: (كان يوم عاشوراء تعدّه عيداً) فعلّق وصف العيد وتعظيم اليهود على يوم عاشوراء، ولا وجه لذلك. وقد مرّ نص اللغويّين على أنّه اسم إسلامي لم يُعرف في الجاهليّة أي قبل الإسلام، وعليه فكيف عرف اليهود عاشوراء قبل الإسلام؟!
وقال في الثاني: (قال النبيّ:فصوموه أنتم ) وقال في الأوّل: (فقال النبيّ:نحن أحقّ بصومه . فأمر بصومه) وجوباً أم استحباباً؟ وظاهر الأمر الوجوب كما
قالوا، وعليه فيخلو الخبر عن ذكر مدى هذا الأمر إلى متى كان أو يكون؟ وكذلك تخلو منه أخبار ابن عبّاس.
ج - وذكرت المدى أخبار عائشة: (فلمّا فرض الله رمضان قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم):(من شاء أنْ يصومه فليصمه، ومن شاء أنْ يتركه فليتركه) .
وقد ذكروا بلا خلاف أنّ فرْض الله صيام شهر رمضان كان بنزول القرآن به لمنتصف السنة الثانية للهجرة، أي أنّه لم يكن بين هجرته وبين نزول القرآن بفرض رمضان غير عاشوراء واحد، وإذا كان قد أمر بصيامه مواساة لموسى (عليه السلام) شكراً لنجاته على قول يهود المدينة له بعد هجرته جواباً عن سؤاله عن صومهم يوم عاشوراء، إذن فعاشوراء الأُولى قد مضت ولم تأتِ الثانية ليصوموا يومها، حتّى نزل القرآن بفرض رمضان فما معنى: (كانوا يصومون عاشوراء قبل أنْ يُفرض رمضان؟ وكذلك ما عن عائشة أيضاً قالت: كان عاشوراء يُصام قبل رمضان، فلمّا نزل رمضان مَن شاء صام ومَن شاء أفطر(١) .
٨ - وعنها قالت: كان رسول الله أمر بصيام عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر(٢) . وكأنّه أمر بالصيام فقط ولم يصوموه.
د - وهناك خبر آخر عن حميد بن عبد الرحمان ، أنّه سمِع معاوية بن أبي سفيان على منبر يوم عاشوراء عام حجّ يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمِعت رسول الله يقول:(هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر) (٣) .
فهذا يتضمّن تنكّراً لصيام قريش في الجاهليّة، ولصيام اليهود كذلك،
____________________
(١) صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، سورة البقرة.
(٢) صحيح البخاري، كتاب الصوم: ٣٠.
(٣) المصدر السابق.
وينصّ من أوّل يوم على الندب والاستحباب دون الوجوب. ولكن يُلاحظ عليه أمران:
الأول: إنّه يتضمّن اعترافاً بعدم علم علماء أهل المدينة بالحديث عن رسول الله.
الثاني: أفكان هذا قبل الهجرة؟ أم بعدها؟ أم بعد فتح مكّة؟ فمتى سمعه معاوية؟ وإذا كان لليهود تقويم عِبري يخصّهم يختلف تمام الاختلاف عن التاريخ العربي القمَري، وإذا لم يكن يوم عاشوراء يوم نجاة موسى (عليه السلام) وبني إسرائيل من فرعون، فلا يصحّ ما جاء في بعض كتب الحديث ممّا نُسِب إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من أخبار في عاشوراء تتضمّن أنّه يوم نجاة موسى وبني إسرائيل من الفراعنة فهو يوم عيد الخلاص.
وإلى جانبه ذكريات أُخرى منها: أنّه يوم خلْق الأرض والجنّة وآدم (عليه السلام) فهو عيد الخلق، وهو يوم نجاة نوح من الغرق، ونجاة إبراهيم من الحرْق(١) .
أمّا علّة وضع هذه الأحاديث فقد روى الشيخ الفقيه أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي، مسنداً عن جبلة المكّيّة قالت: سمعت ميثم التّمار يقول: (والله لتقتلنّ هذه الأُمّة ابن نبيّها في المحرّم لعشرٍ مضين منه، وليتخذنّ أعداء الله ذلك اليوم يوم بركة، وأنّ ذلك لكائن قد سبق في علم الله تعالى ذكره، أعلم بذلك بعهدٍ عهِده إليّ مولاي أمير المؤمنين (صلّى الله عليه وآله وسلّم).
قالت جبلة: فقلت: يا ميثم، وكيف يتّخذ الناس ذلك اليوم الذي يُقتل فيه الحسين بن عليّ (عليهما السلام) يوم بركة؟!
فبكى ميثم، ثمّ قال: سيزعمون - بحديث يضعونه - أنّه اليوم الذي تاب الله
____________________
(١) تفصيل الرد تجده في مجلّة رسالة الثقلين العدد الثاني - يوم عاشوراء في اللغة والتاريخ والحديث.
فيه على آدم (عليه السلام) وإنّما تاب الله على آدم في ذي الحجّة. ويزعمون أنّه اليوم الذي استوت فيه سفينة نوحٍ على الجودي، وإنما استوت على الجودي يوم الثامن عشر من ذي الحجّة.
ويزعمون أنّه اليوم الذي فلق الله فيه البحر لبني إسرائيل. وإنّما كان ذلك في شهر ربيع الأوّل(١) .
ويزعمون أنّه اليوم الذي قَبل الله فيه توبة داود، وإنّما قبل الله توبته في ذي الحجّة. ويزعمون أنّه اليوم الذي أخرج الله فيه يونس من بطن الحوت، وإنّما أخرجه الله من بطن الحوت في ذي القعدة.
ثمّ قال ميثم: يا جبلة، إذا نظرت إلى الشمس حمراء كأنّها دمٌ عبيط، فاعلمي أنّ سيّدك الحسين (عليه السلام) قد قُتِل)(٢) .
أمّا قول(بيرك) تحت نفس المادّة وكذلك قول(سبرنجر) وقول(نولدكه وشفالي) فهي مجرّد فرضيّات وادّعاءات احتماليّة لم يسوقوا أيّ دليلٍ أو قرينةٍ عليها، ويرد عليها ما أوردناه على قول(هيك) تحت مادّة (سحر) فراجع. على أنّ قول(بيرك): - (وفيما يتعلّق بمسألة السبب الذي من أجله اختار محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) شهر رمضان بالذات... قيلت آراءٌ عديدة) - لا مورد له؛ لأنّ الله سبحانه قد أظهر سرّ عظمة هذا الشهر في قوله تعالى:
( شَهْرُ رَمَضَانَ الّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنّاسِ وَبَيّنَاتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقَانِ ) (٣) فجعل أداء هذه الفريضة العظيمة في
____________________
(١) وهذا يتّفق مع ظاهر أخبار ابن عبّاس وأبي موسى الأشعري في أنّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لمّا قدم المدينة - وقدِمها في ربيع الأوّل بلا خلاف - رأى اليهود يصومون اليوم ويقولون أنّه يوم نجاة موسى وبني إسرائيل من فرعون والغرق، لا يوم عاشوراء.
(٢) أمالي الشيخ الصدوق: ١١٠ط. بيروت.
(٣) البقرة: ١٨٥.
الشهر العظيم فقال سبحانه: ( فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (١) .
٩ - قول(فير) تحت مادّة(الجاهليّة) وقول(فنسنك) تحت مادّة (أصل الحجّ في الإسلام)، وقوله أيضاً تحت مادّة(إحرام) ، وما نقله عن(سنوك هجروينيه) تحت نفس المادّة، وقول(بول) تحت مادّة(الجمرة) ، وقول(شاخت) تحت مادّة(زكاة) وقوله أيضاً تحت مادّة(زنى) ، وقول(هفننج) تحت مادّة(التجارة)، يرد عليها جميعاً ما أوردناه سابقاً على قول(هيك) تحت مادّة(سحر).
يُضاف إلى ذلك أن هذه الأقوال فيها روح الإنكار للوحي الإلهي للرسول محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وخصوصاً ما هو تحت مادّة( الجاهليّة) ومادّة (أصل الحجّ في الإسلام) ومادّة (إحرام)، إذ يكفيها جواباً أنّ القرآن الكريم يُصرّح في أكثر من آيةٍ كريمة، أنّ بيت الله الحرام هو واحد، وقد أقام قواعده نبيّ الله إبراهيم (عليه السلام) وولده نبي الله إسماعيل (عليه السلام) وذلك في قوله تعالى:
( وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبّنَا تَقَبّلْ مِنّا إِنّكَ أَنْتَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ ) (٢) ، ثمّ أمر الله سبحانه نبيّه إبراهيم (عليه السلام) أنْ يُطهّر هذا البيت لأداء عبادة الحجّ الإلهي، حيثُ جاء في القرآن الكريم عن ذلك:
( وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ * وَأَذّن فِي النّاسِ بِالْحَجّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلّ فَجّ عَمِيقٍ ) (٣) ، وقوله تعالى أيضاً:
( وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنّاسِ وَأَمْناً وَاتّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهّرَا بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرّكّعِ السّجُودِ ) (٤) . واستمرّ الحال زمناً طويلاً
____________________
(١) البقرة: ١٨٥.
(٢) البقرة: ١٢٧.
(٣) الحج: ٢٦، ٢٧.
(٤) البقرة: ١٢٥.
حتّى أفسد أهل الجاهليّة هذا الحجّ الإبراهيمي، وحرّفوه عن شرعته الإلهيّة باتّخاذهم الأصنام في بيت الله وشعائر الحجّ الأخرى شركاء لله سبحانه يتقربون إليها دونه تعالى، ومحقوا صورته الأولى التي شرّعها الله لنبيّه إبراهيم (عليه السلام)، واستبدلوها بالدجل والهراء، حتّى وصفهم القرآن الكريم بقوله:
( وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاّ مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ) (١) ، فأمر الله تعالى نبيّه الكريم محمّداً (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، بإعادة عبادة الحجّ الإلهي إلى صورته الأُولى، إمضاءً لشريعة إبراهيم (عليه السلام) فيها، حيثُ قال في قرآنه المجيد: ( إِنّ أَوّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلّذِي بِبَكّةَ مُبَارَكاً وَهُدىً لِلْعَالَمِينَ * فِيهِ آيَاتٌ بَيّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَللّهِِ عَلَى النّاسِ حِجّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنّ اللّهَ غَنِيّ عَنِ الْعَالَمِينَ ) (٢) .
كما أنّ قول(بول) تحت مادّة(الجمرة): جهلٌ منه أو تجاهل، فإنّ كثيراً من مفردات الشريعة الإسلاميّة جاءت كليّات في القرآن الكريم، ثمّ فصّلها الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في حديثه وسيرته الشريفة، بوحيٍ وإلهامٍ من الله سبحانه وتعالى.
١٠ - قول(هـ. هـ. بروى) تحت مادّة(أُميّة بن أبي الصلت) صارخ في إنكار الوحي الإلهي للرسول محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وهو يردّد بذلك دعوى أسلافه من اليهود والنصارى من الذين ابتدعوا هذه الأشعار، ونسبوها إلى أميّة كيداً للإسلام ونبيّه الكريم (صلّى الله عليه وآله وسلّم).
وقد ذكرت لنا كتب التاريخ أنّ أُميّة بن الصلت هذا كان من أعدى أعداء الإسلام ونبيّه الكريم (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من ذلك ما جاء في تاريخ الأدب العربي في ترجمة أُميّة بن الصلت ما نصّه: (كان أُميّة تاجراً من أهل الطائف ينتقل بتجارته بين الشام واليمن. ومال أُميّة من أول أمره إلى التحنّف، هجر عبادة الأوثان وترك شرب
____________________
(١) الأنفال: ٣٥.
(٢) آل عمران: ٩٦ - ٩٧.
الخمر واعتقد بوجود الله من غير أنْ يكون له فروض معينة في العبادة. وكاد أُميّة أنْ يسلِم لمّا جاء الإسلام، ولكن موقف قومه ثقيفٍ من الإسلام أملى عليه العداء للرسول وللمسلمين، فكان يُحرّض على قتال الرسول، ولمّا انتصر المسلمون على مشركي مكّة في غزوة بدرٍ، في رمضان من سنة ٢ للهجرة، رثى أُميّة الذين قُتلوا من المشركين في تلك الغزوة...ضاع القسم الأوفر من شعر أُميّة، ولم يثبت له على القطع سوى قصيدته في رثاء قتلى بدر من المشركين.
وكان أُميّة يحكي في شعره قصص الأنبياء على ما جاء في التوراة ويذكر الله والحشر، ويأتي بالألفاظ والتعابير على غير مألوف العرب، ولذلك كان اللغويّون لا يحتجون بشعره. وشعره كثير التكلّف ضعيف البناء قليل الرونق قلق الألفاظ. أمّا أغراضه في شعره الباقي بين أيدينا - صحيحاً ومنحولاً - فهي المدح والهجاء والرثاء وشيء من الحكمة وكثير من الزهد والتزهيد، ومن الكلام في الله والآخرة)(١) .
ومن ذلك نستنتج ما يلي:
١ - إنّه كان عدوّاً للإسلام ولرسوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) حتّى نُقل أنّه: لمّا ظهَر النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قيل له: هذا الذي كنت تستريب وتقول فيه. فحسده عدوّ الله وقال: إنّما كنت أرجو أنْ أكونَه، فأنزل الله تعالى فيه: ( وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا ) [الأعراف: ١٧٥].
وكان يحرّض قريشاً بعد وقعة بدر)(٢) ، وهذه قرينة على وجود تنافر بينه وبين رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ممّا يبعد مقولة وجود صلة واستقاء منه خصوصاً بعد البعثة النبويّة.
٢ - إنّه كان يحكي في شعره بعض ما جاء في التوراة من قصص الأنبياء
____________________
(١) تاريخ الأدب العربي للدكتور عمر فروخ ١: ٢١٦ - ٢١٧.
(٢) كتاب الوافي بالوفيّات لصلاح الدين خليل أيبك الصفدي ٩: ٣٩٥ - ٣٩٦، والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ٤: ١٢٧.
وذكر الله والحشر ويأتي بالألفاظ والتعابير على غير مألوف العرب. وعليه فلو أراد الرسول أنْ يستقي هذه الأمور لاستقاها من التوراة مباشرة دون الحاجة إلى أشعار أُميّة خصوصاً وإنّ شعره متكلّف ضعيف البناء قليل الرونق قلق الألفاظ لا يؤدّي إلى المراد بالدقّة المطلوبة، ويؤيّد ذلك ما ذكره المؤرخون بقولهم: (ولذلك كان اللغويّون لا يحتجّون بشعره).
٣ - إنّ البيان والبلاغة الإعجازيّة لآيات القرآن الكريم تأبى وتتنافى ودعوى الأخذ من أشعار أُميّة المتكلّفة الضعيفة القلقة القليلة الرونق.
وقد أشار القرآن إلى هذه الافتراءات وما فيها من مفارقات صارخة، وأفحمهم بالبرهان الساطع الذي يثبت به - بما لا يقبل الشكّ والترديد - البَون المُطلق بين ما يُدّعى مصدراً لضعفه وهبوط بيانه، وبين البيان الإعجازي للقرآن الكريم وهو قوله تعالى:
( وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنّهُمْ يَقُولُونَ إِنّمَا يُعَلّمُهُ بَشَرٌ لّسَانُ الّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيّ وَهذَا لِسَانٌ عَرَبِيّ مُبِينٌ ) (١) ، ثُمّ أشار إلى حقيقة أُخرى تدفع هذه الدعوى أيضاً إذ قال:
( تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هذَا فَاصْبِرْ إِنّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتّقِينَ ) (٢) ، وبذلك أثبت أنّ المشركين آنذاك لا يعلمون ممّا جاء في القرآن شيئاً، ولو كانت أشعار أُميّة مطابقة أو مشابهة لِما ورد في القرآن الكريم، إذن لكانت خير دليلٍ عندهم على دحض نبوّة محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وإنكار الوحي والتنزيل الإلهي له (صلّى الله عليه وآله وسلّم).
ونضيف إلى ذلك ردّنا السابق على قول(هيك) تحت مادّة(سحر) ، في أنّنا لا نعدم وجود مشتركات وتشابه بين بعض المفردات في الإسلام والقرآن الكريم، ومفردات في اليهوديّة والنصرانيّة وكتابيهما التوراة والإنجيل، في الموارد التي لم
____________________
(١) النحل: ١٠٣.
(٢) هود: ٤٩.
يطِلْها التحريف خصوصاً في كلّيّات الاعتقادات وقصص الأنبياء لِعَدم شمول النسخ لها كما ذكرنا سابقاً، فراجع.
شعائر الإسلام وليدة إبداعات وتأثيرات متنوّعة
وفيها يُحاول بعض كتّاب هذه الدائرة اختلاق ودعم شبهة أنّ شعائر الإسلام جاءت من خلال إبداعات خاصّة أو تأثيرات متنوّعة: (كالصحابة، الجاهليّة، اليهوديّة، النصرانيّة، الفارسيّة، و...).
ومن نماذج الدسّ والتشويه في صيغة هذه الشبهة ما جاء تحت مادّة(أذان) التي يقول فيها(جوينبل Th.Juynboll ) : (وتقول الرواية الإسلاميّة: إنّ النبيّ تشاوَر مع أصحابه بعد دخوله المدينة مباشرةً، في العام الأوّل أو الثاني للهجرة، في خير الطرق لتنبيه المؤمنين إلى وقت الصلاة، فاقترح بعضهم أنْ يُوقدوا لذلك ناراً أو ينفخوا في بوق أو يدقّوا ناقوساً، (مثل قطعة طويلة من الخشب تضرب بقطعة أُخرى وكان يستعمله المسيحيّون في الشرق للتنبيه إلى الصلاة)، ولكنّ واحداً من المسلمين هو عبد الله بن زيد أخبر أنّه رأى في المنام رجلاً يدعو المسلمين إلى الصلاة من سقف المسجد، وامتدح عُمر هذه الطريقة في الدعوة إلى الصلاة، ولمّا اتّفق رأي الجماعة على هذا الأذان أمر النبيّ باتّباعه، ومن ذلك الوقت أخذ بلال يُنادي المؤمنين إلى الصلاة بهذا الأذان، الذي يستعمله العالم الإسلامي إلى وقتنا هذا)(١) .
وتحت باب(بلال) يقول( Fr. Buhl ): (وأدخل النبيّ الأذان بعد أنْ أبدى
____________________
(١) دائرة المعارف الإسلاميّة ١: ٥٦٠.
شيئاً من التردّد (انظر مادّة أذان) وجعل بلالاً مؤذّناً له)(١) .
ويسفّ(كاستر M. Gaster ) أكثر فيقول عن(القبلة) تحت باب(السامرة): (وقد ورد في الإنصرة أيضاً كلمة القبلة، أي التوجّه في الصلاة إلى الجبل المقدّس. والحق في أنّ الاتّجاه إلى المعبد معروف أيضاً عند اليهود... ويجوز أنّ محمّداً أخذ هذه الشعيرة من السامرة، وقد صبغها مثلهم بصبغة دينيّة خاصّة، أقوى وأشدّ ممّا يفعل اليهود، وكذلك غيّر محمّدٌ وجهة الصلاة عندما اختلف مع اليهود، وبذلك أفصح عن الأهميّة التي كان ينسبها إلى القبلة)(٢) .
أمّا(فنسنك A. J. Wensink ) فينقل هذه الشبهة إلى أهمّ شعائر الإسلام على الإطلاق، وهي الصلاة فيقول تحت مادّتها: (ويبدو أنّ كلمة صلاة لم تظهر في الآثار الأدبيّة السابقة على القرآن، وقد اتّخذها محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كما اتّخذ الشعيرة من اليهود والمسيحيّين في بلاد العرب)(٣) .
ويستمرّ(فنسنك) في إبرام شبهته هذه فيقول تحت المادّة نفسها:( واشتقاق كلمة(صلوطا) الآراميّة واضح كلّ الوضوح، فالأصل(صلأ) ، في الآراميّة يعني الانحناء والانثناء والقيام... وتُستعمل في كثير من اللهجات الآراميّة للدلالة على الصلاة الشرعيّة... وقد نقل محمّد كلمة الصلاة بهذا المعنى من جيرانه.
ويكشف نظام الصلاة عند المسلمين عن تشابه كبير بصلاة اليهود والمسيحيّين... ومن البيّن أنّ محمّداً لم تكن بين يديه أوّل الأمر المادّة الوافية لهذه الشعيرة؛ ولقد كانت تعوزه النصوص التي يتلوها ويرتّلها اليهود والمسيحيّون في
____________________
(١) دائرة المعارف الإسلاميّة ٤: ٧٣.
(٢) المصدر السابق ١١: ٩٢.
(٣) المصدر السابق ١٤: ٢٧٧.
صلاتهم) (١) .
ويستمر(فنسنك) تحت المادّة نفسها قائلاً: (ومن ثمّ فنحن نجد فجأةً الصلاة الوسطى تظهر في السورة المدنيّة وهي البقرة، الآية ٢٣٧. ولا بد إذن أنْ تكون هذه الصلاة قد أُضيفت في المدينة إلى الصلاتين المعتادتين، ويرجّح أنْ يكون ذلك قد تمّ محاكاةً لليهود الذين كانوا يُقيمون أيضاً صلاتهم(ثقلاه) ثلاث مرّات كلّ يوم)(٢) .
ويقول أيضاً: إنّ(جولد صيهر Gold Ziher ) وفي معرض ردّه على(هوتسما) في كيفيّة تقرير الصلوات الخمس، يرى عكس ما يراه الأخير ويذهب إلى القول بوجود أثر فارسي في تقرير الصلوات الخمس(٣) .
وعن عدد الركعات في الصلوات الخمس يقول(فنسنك) تحت مادّة(الصلاة):
(... إنّ الحديث [النبويّ] يقول أيضاً: إنّ الصلاة كانت في الأصل من ركعتين وإنّ هذا العدد نفسه عمل به في صلاة السفر... ويفترض(متفوخ) وجود التأثير اليهودي في الاختيار الأصلي للركعتين)(٤) .
وردّنا على مفردات هذه الصياغة من الدسّ، والتشويه، واختلاف الشبهات كالآتي:
أ - قول(جوينبل) تحت مادّة(أذان) وقول(بول) تحت مادّة(بلال) يرد عليه: إن مثل هذه الرواية التي ادّعاها (جوينبل) ولم يذكر لنا مصدرها، لا شكّ إنّها من المختلقات الإسرائيليّة التي اشتهر أمرها وحذّر العلماء وأهل الحديث
____________________
(١) المصدر السابق ١٤: ٢٧٨.
(٢) المصدر السابق ١٤: ٢٨١.
(٣) المصدر السابق ١٤: ٢٨٢.
(٤) المصدر السابق ١٤: ٢٨٦.
والرواية منها، أمّا الروايات الصحيحة التي وردت عن أئمّة أهل بيت النبوّة والعصمة (عليهم السلام) فهي على خلاف ذلك، حيث تنصّ على أنّ الأذان كان من الله بواسطة الوحي(جبرئيل)، بل إنّ بعضاً منها تضمّن استنكاراً وزجراً ولعناً لِمَن زعموا أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أخذ الأذان عن عبد الله بن زيد.
ومن هذه الروايات ما عن محمّد بن يعقوب عن أبيه عن ابن أبي عُمير عن حمّاد عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:(لمّا هبط جبرئيل (عليه السلام) بالأذان على رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، كان رأسه في حِجْر عليّ (عليه السلام)، فأذّن جبرئيل وأقام، فلمّا انتبه رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال: يا علي، سمِعت؟ قال: نعم، قال: حفظت؟ قال: نعم، قال: ادع بلالاً فعلّمه، فدعا عليّ (عليه السلام) بلالاً فعلّمه).
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم، وروى الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله.
وعن محمّد بن مكّي الشهيد في الذكرى: عن ابن أبي عقيل عن الصادق (عليه السلام) أنّه (لعن قوماً زعموا أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أخذ الأذان من عبد الله بن زيد، فقال:(ينزل الوحي على نبيّكم فتزعمون أنّه أخذ الأذان من عبد الله بن زيد؟!) (١) .
ب - قول(كاستر) فيما يتعلّق بالقبلة تحت باب(السامرة) فيه: ما أوردناه على قول(هيك) تحت مادّة(سحر) وقول(ر. پاريه) تحت مادّة(أمّة) فراجع.
على أنّ قضيّة القبلة لم تكن بالشكل الذي عرضه(كاستر) ، هذا من أنّ الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) غيّر القبلة عندما اختلف مع اليهود، بل كان أمراً إلهيّاً للردّ على دعوى اليهود التي ردّدها(كاستر) في قوله السالف من تبعيّة الإسلام ورسوله الكريم (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لهم، بدليل اتّخاذه (بيت المقدّس) التي هي قبلة اليهود قبلةً للمسلمين،
____________________
(١) وسائل الشيعة ٤: ٦١٢ - ٦١٣، ح٣.
وبهذا الأمر الإلهي تميّز المسلمون عن اليهود بجعل الكعبة المشرّفة قبلتهم دون سواهم.
وفي بيان هذه الحقيقة روى عليّ بن إبراهيم بإسناده عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: (تحوّلت القبلة إلى الكعبة بعدما صلّى النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بمكّة، ثلاث عشرة سنة إلى بيت المقدِس، وبعد مهاجرته إلى المدينة صلّى إلى بيت المقدِس سبعه أشهر، قال: ثمّ وجّهه الله إلى الكعبة، وذلك أنّ اليهود كانوا يعيّرون رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ويقولون له:
أنت تابع لنا، تصلّي إلى قبلتنا، فاغتمَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من ذلك غمَّاً شديداً، وخرج في جوف الليل ينظر إلى آفاق السماء، ينتظر مِن الله تعالى في ذلك أمراً، فلمّا أصبح وحضر وقت صلاة الظهر، كان في مسجد بني سالم قد صلّى من الظهر ركعتين، فنزل جبرئيل (عليه السلام) فأخذ بعَضُديه وحوّله إلى الكعبة، وأنزل عليه:
( قَدْ نَرَى تَقَلّبَ وَجْهِكَ فِي السّماءِ فَلَنُوَلّيَنّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.... ) ، وكان صلّى ركعتين إلى بيت المقدِس وركعتين إلى الكعبة، فقالت اليهود والسفهاء:
( ...مَا وَلاّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الّتِي كَانُوا عَلَيْهَا... ) (١) .
ج - أقوال(فنسنك) المتعدّدة تحت مادّة(الصلاة) يرد عليها جميعاً ما أوردناه على(هيك) تحت مادّة(سحر) فراجع. ونضيف إليه:
١ - قوله: (ويبدو أنّ كلمة صلاة لم تظهر في الآثار الأدبيّة السابقة على القرآن...)، فيرد عليه ما أوردناه على(ر. پاريه) تحت مادّة(أُمّة)، مع تأكيدنا على بطلان ما ادّعاه، فإنّ كلمة صلاة وردت في الشعر العربي الجاهلي قَبل نزول القرآن الكريم، كما في قول أعشى قيس:
يُراوِح في صَلواتِهِ لِمَلِيك * طَورَاً سُجودَاً وطَورَاً جوار
____________________
(١) مجمع البيان ١: ٢٢٣.
ومعنى الصلاة لغة الدعاء والاستغفار؛ فقد قال الأعشى أيضاً:
لها حارسٌ لا يَبرَح الدهر بَيتَها * فإنْ ذبحت صلّى عليها وزمزما
أي دعا لها، وقال أيضاً:
وقابلها الريح في دنّها * وصلّى على دنّها وارتسم
أي دعا لها أنْ لا تحمض ولا تفسدَ. والصلاة من الله تعالى: الرحمة، قال عدِي بن الرقاع:
صلّى الإله على امرئ ودّعتُه * وأتمّ نعمته عليه وزادها
وقال:
صلّى على عزّة الرحمان وابنتها * ليلى، وصلّى على جاراتها الأُخر(١)
وأصل الاشتقاق في الصلاة من اللزوم من قوله: ( تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً ) ، والمصدر(الصلا) ، ومنه اصطلى بالنار إذا لزمها، والمصلِّي الذي يجيء في أثر السابق للزوم أثره، ويُقال للعظم الذي في العجز صلاً، وهما صلوان.
أمّا في اصطلاح الشريعة الإسلاميّة، فهي عبارة عن العبادة الخاصّة التي شرعها الإسلام والمشتملة على الركوع والسجود على وجهٍ مخصوص وأركانٍ وأذكارٍ مخصوصة.
وقيل إنّها سُمّيت صلاة لأنّ المصلّي متعرّض لاستنجاح طلبته، من ثوابِ الله ونِعَمه مع ما يسأل ربّه فيها مِن حاجاته(٢) .
٢ - قوله: إنّ نظام الصلاة عند المسلمين يُشابه بدرجةٍ كبيرة صلاة اليهود والمسيحيّين... وإنّ الصلاة الوسطى ظهرت فجأة في سورة البقرة المدنية، وإنّها أُضيفت إلى الصلاتين المعتادتين فأصبحت ثلاثة، ثمّ يفرّع عليها رجحان أنّ ذلك
____________________
(١) لسان العرب: ماّدة (صلاة).
(٢) الطوسي، البيان ١: ٥٦ - ٥٧.
قد تمَّ محاكاةً لصلاة اليهود(ثقلاه) (١) التي تقام ثلاث مرّات كلّ يوم.
يرد عليها أنّ التشابه يكون مرّة بعدد الصلوات، وأُخرى بشكليّة الصلاة مِن قيامٍ وركوعٍ وسجودٍ وأمثالها، وثالثة بمضامين الصلاة من قراءات وأذكار، أمّا الجانب الأوّل فإنّ الصلاة التي شرّعها الإسلام، هي خمس صلوات وليس ثلاث صلوات، كما لدى اليهود حسب قول(فنسنك) نفسه، وليست سبعاً كما لدى المسيحيّين وهي: (صلاة البكور وصلاة الساعة الثالثة، والسادسة والتاسعة، والحادية عشرة والثانية عشرة ثمّ صلاة منتصف الليل)(٢) .
والصلوات الإسلاميّة الخمسة هذه محدّدة أوقاتها بموجب آيتين قرآنيّتين نزلتا على الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في مكّة المكّرمة وليس في المدينة المنوّرة، وهما في سورة الإسراء في قوله تعالى:
( أَقِمِ الصّلاَةَ لِدُلُوكِ الشّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً ) (٣) ، وفي سورة هود في قوله تعالى: ( وَأَقِمِ الصّلاَةَ طَرَفَيِ النّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللّيْلِ... ) (٤) .
وفي بيان دلالة هاتين الآيتين، روي عن زرارة مسنداً قال: (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عمّا فرض الله عزّ وجل من الصلاة، فقال:(خمسَ صلواتٍ في الليلِ والنهار)، فقلت: هل سمّاهنّ الله وبيّنهن في كتابه؟ قال:(نعم، قال الله تعالى لنبيّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم): ( أَقِمِ الصّلاَةَ لِدُلُوكِ الشّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللّيْلِ ) ودلوكها زوالها، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات، سمّاهنّ الله وبيّنهنّ ووقّتهنّ، وغسق الليل هو انتصافه، ثم قال تبارك وتعالى: ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنّ قُرْآنَ الْفَجْرِ
كَانَ مَشْهُوداً ) ، فهذه الخامسة، وقال تبارك وتعالى في ذلك: ( أَقِمِ الصّلاَةَ طَرَفَيِ النّهَارِ ) وطَرَفاه: المغرب والغداة ( وَزُلَفاً مِنَ اللّيْلِ ) وهي صلاة العشاء الآخرة...)(١) .
وفي تفسير الآية الأولى قال ابن عبّاس والحسن ومجاهد وقتادة: (دلوكها زوالها، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)... وقال الجبائي: غسَق الليل ظُلمته، وهو وقت العشاء... وقال الحسن:(لدلوك الشمس) لزوالها: صلاة الظهر، وصلاة العصر إلى(غسق الليل) صلاة المغرب والعشاء الآخرة، كأنّه يقول من ذلك الوقت إلى هذا الوقت على ما يُبيّن لك مِن حال الصلوات الأربع، ثمّ صلاة الفجر، فأُفرِدت بالذكر)(٢) .
أمّا الصلاة الوسطى الواردة في سورة البقرة: ( حافِظُوا عَلَى الصّلَوَاتِ وَالصّلاَةِ الْوُسْطَى ) (٣) فقد جاء في معنى الآية: الحثّ على مراعاة الصلوات، ومواقيتهنّ، وألاّ يقع فيها تضييع وتفريط(٤) .
وجاء في روايات متعدّدة أنّ الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، منها ما رُوي مسنداً عن أبي جعفر (عليه السلام) (في حديث) قال:(وقال تعالى: ( حافِظُوا عَلَى الصّلَوَاتِ وَالصّلاَةِ الْوُسْطَى ) وهي صلاة الظهر) (٥) .
وعليه فلا يضُرّ أنْ تكون هذه الآية مدنيّة؛ لأنّها لم تكن بصدد أصل تشريع الصلوات الخمس، بل جاءت للحثّ على مراعاة الصلوات ومواقيتهن، وخصوصاً الصلاة الوسطى منهنّ والتي سبَق تشريعها في الآيات المكيّة السالفة الذكر، وبهذا
____________________
(١) وسائل الشيعة ٣: ٥، ح١.
(٢) الطوسي، التبيان ٦: ٥٠٩ - ٥١٠.
(٣) البقرة: ٢٣٨.
(٤) الطوسي، التبيان ٢: ٢٧٥.
(٥) وسائل الشيعة ٣: ١٤، ح١.
تبطل دعوى فنسنك: بأنّها أُضيفت في المدينة إلى الصلاتين المعتادتين، ويبطل أيضا قوله: بأنّها ثلاث صلوات أو ثلاث مرّات، والتي يفرع عليها دعوى محاكاتها لصلاة اليهود(ثقلاه) ، كما يبطل مشابهتها لصلوات المسيحيّين من هذه الناحية لثبوت أنّ الصلوات المشرعة هي خمس وليست ثلاثاً كما عند اليهود، وليست سبعاً كما لدى المسيحيّين كما أسلفنا.
أمّا الجانبان الثاني والثالث من التشابه المدّعى ففيه: أنّه ورد (أنّ الأصل في جميع صلوات المسيحيّين إنّما هو الصلاة الربانيّة التي علّمها السيّد المسيح، والأصل في تلاوتها أنْ يتلوها المصلّي ساجداً، وقد تكون الصلاة لفظيّة، بأنْ تُتلى بألفاظٍ منقولة أو مرتجلة، وتكون عقليّة بأنْ تنوى الألفاظ ويكون الابتهال قلبيّاً محضاً)(١) .
ثمّ يحكي لنا مصدر آخر كيفيّة تطوّر صلواتهم قائلا: (نشَر [الرهبان] الفرنسسكان عادة(طريق الصليب) أو(مواضعه) ، وهي التي تقضي بأنْ يتلو المتعبّد صلوات أمام صورة أو لوحة من لوحات أو صور أربع عشرة، تمثّل كل منها مرحلة من مراحل آلام المسيح؛ فكان القساوسة والرهبان والراهبات وبعض العلمانيّين ينشدون أو يتلون أدعية الساعات القانونيّة وهي: أدعية، وقراءات، ومزامير، وترانيم صاغهاالبندكتيون وغيرهم، وجمعها(ألكوين Alcuin ) و(جريجوري السابع) في كتاب موجز.
وكانت هذه الأدعية تَطرق أبواب السماء... كلّ يوم وليلة في فترات، بين كلّ واحدة والتي تليها ثلاث ساعات)(٢) .
وعن مضامينها يقول المصدر نفسه: (وأقدم الصلوات المسيحيّة هما:
____________________
(١) المعلّم البستاني، بطرس، دائرة المعارف ١٠: ١٠. مادّة (الصلاة).
(٢) ديورانت، ول، قصّة الحضارة ١٦: ٢١ - ٢٢. فصل الصلاة.
الصلاة التي مطلعها(أبانا الذي في السماوات) ، والتي مطلعها(نؤمن بإلهٍ واحد) ، وقبل أنْ ينتهي القرن الثاني عشر بدأت الصلاة التي مطلعها:(السلام لك يا مريم) تتّخذ صيغتها المعروفة، وكانت هناك غير الصلوات أوراد شعريّة من الثناء والتضرّع،... وكثيراً ما كانت الصلوات الرسميّة التي تُتلى في الكنائس توجَّه إلى الله الأب، وكان عدد قليل منها يوجّه إلى الروح القدس؛ ولكن صلوات الشعب كانت توجّه في الأغلب إلى عيسى ومريم، والقديسين)(١) .
أمّا صلاة اليهود فقد ورد عنها القول: (أمّا اليهود فليس في التوراة ما يدلّ دلالةً صريحةً على كيفيّة إقامة الصلاة عندهم، والظاهر أنّهم إنّما كانوا يتلونها وقوفاً إلاّ في الاحتفالات الكبرى، حيثُ كانوا يسجدون، وكان لها ثلاثة أوقات قانونيّة: الصبح والظهر والمساء)(٢) .
أمّا الصلوات في الإسلام فقد ذكر الفقهاء كيفيّتها، استناداً على الأدلّة الشرعيّة من القرآن الكريم والسنّة الشريفة فقالوا: (... فهي تتكوّن من ركعات، والحدّ الأقصى من الركَعَات في الصلاة أربعة، كصلاة العشاء مثلاً، والحدّ الأدنى من الركَعَات في الصلوات الواجبة ركعتان كصلاة الصبح، وفي الصلوات المندوبة ركعة واحدة وهي ركعة الوتر.
وعلى العموم فالرَكَعَات هي: الوحدات والأجزاء الأساسيّة التي تتكوّن منها الصلاة، ويُستثنى من ذلك الصلاة على الأموات، فإنّها مكوّنة من تكبيرات لا من رَكَعَات، وليست هي صلاة إلاّ بالاسم فقط)(٣) .
____________________
(١) المصدر السابق.
(٢) المعلّم البستاني، بطرس، دائرة المعارف ١٠: ١٠ مادّة (الصلاة).
(٣) لمزيد من التفصيل في أجزاء وكيفيّة الصلوات اليوميّة في الإسلام يراجع: السيّد الصدر، محمّد باقر، الفتاوى الواضحة: ٢٥٨ - ٢٦٠.
وهناك شروط يجب توافرها في كلّ صلاة وهي على قسمين: أحدهما شروط للمصلّي، والآخر شروط لنفس الصلاة، وأهمّها أن يكون المصلّي على وضوءٍ وطهارة، وأنْ يكون بدَنَهُ طاهراً وكذلك ثيابه، وأنْ يستقبل القبلة (وهي الكعبة المشرّفة) وأنْ يقصد بالصلاة القُربة إلى الله تعالى(١) .
وقد وردت روايات كثيرة عن الكيفيّة وعن مضامينها وأجزائها، وشروط ذكرتها كتب الحديث في باب الصلاة(٢) .
بعد هذا الاستعراض نرى بالمقارنة بين الصلوات لدى اليهود ولدى المسيحيّين، وبين الصلوات في الإسلام وجود اختلافٍ أساسيٍّ بينها، في العدد وفي الأوقات وفي شكليّاتها ومضامينها. فمِن أين استنتج(فنسنك) التشابه الكبير بينها ومحاكاة بعضها لبعض، وأمثال ذلك في المقولات والدَعَوات الجزافيّة التي لا دليل ولا شاهد عليها؟
هذا مع العلم أنّنا نلحظ من خلال سَوقنا لِما نُقل عن صلاة اليهود وصلوات المسيحيّين، أنّ يد التغيير البشريّة قد طالت الأصل، وأحدثت فيه الشيء الكثير، إذ نجد أنّ مفرداتها - وخصوصاً صلوات المسيحيّين - غدَت مشبّعة بمبدأ التثليث الذي هو من مقولات الشرك بالله سبحانه وتعالى، بخلاف مبدأ التوحيد والإخلاص لله وحده لا شريك له في العبادات الإسلاميّة، الذي تعبّر عنه جميع مفرداتها، وخصوصاً الصلاة منها التي يشترط فيها كما أسلفنا نيّة التقرّب لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، وهذا ما يؤكّد حقيقة التحريف في الديانتين اليهوديّة والمسيحيّة وفي كتابَيهما التوراة والانجيل، والتي لا نعدم وجود تشابه في أُصولِهما قبل التحريف بين الأحكام
____________________
(١) المصدر: ٢٦١.
(٢) منها: وسائل الشيعة للحرّ العاملي - أبواب أفعال الصلاة - وبحار الأنوار للمجلسي - كتاب الصلاة. وغيرها من كتب الحديث.
الواردة فيهما والتي لم تنسخ، وبين نظائرها من الأحكام الواردة في القرآن الكريم والسنة الشريفة، لأنّها من سراجٍ واحدٍ كما أسلفنا.
غموض العديد من مقولات النبيّ محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) القرآنيّة
وتهدف هذه الشبهة إلى تكوين دليل على نفي الوحي بالقرآن، وأنّه إمّا من مخترعات النبيّ محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أو أنّه اقتبسه من الغير.
وتتركّز هذه الصياغة للشبهة على مجموعة من الصفات الإلهيّة والأسماء والمصطلحات الخاصّة، الواردة في القرآن الكريم، منها ما ادّعاه(ماكدونالد D. B. Macdonald ) تحت مادّة(الله) (ج - الله في ذاته ولذاته) قائلاً: (وصَفة القدّوس وحدها من أسماء الله الحسنى، ولكنّها لا ترد إلاّ مع كلمة ملك، ولسنا نعرف على وجه التحقيق المعنى الذي يريده محمّد من كلمة قدّوس...)(١) .
ويقول أيضاً في المادّة نفسها: (ومن أسمائه أيضاً السلام (سورة الحشر، الآية ٢٣). وهذه الصفة لم ترد إلاّ في الآية ٢٣ من سورة الحشر، ومعناها شديد الغموض، ونكاد نقطع بأنّها لا تعني(السلم) . ويرى المفسّرون أنّ معناها(السلامة) أي البراءة من النقائص والعُيوب، وهو تفسيرٌ محتمل، وقد تكون هذه الصفة كلمةٌ بقيت في ذاكرة محمّد من العبارات التي تُتلى في صلوات النصارى)(٢) .
ويقول أيضاً: (... أمّا صفاته المعنويّة فقد وردت في قلّة يشوبها الغموض، فإنّه يصعب علينا معرفة ما يَقصده محمّد من صفات(القدّوس) و(السلام)
____________________
(١) دائرة المعارف الإسلاميّة ٢: ٥٦٢.
(٢) المصدر السابق ٢: ٥٦٣.
و(النور). وهناك مجال للشكّ فيما إذا كان محمّد قد رأى من المناسب أنْ يطلق على الله صفة(العدل) (١) .
أمّا تحت مادّة(الله) (د - صلة الخالق بخلقه) فيقول: (ومن الواضح أنّ صفة البارئ قد أخذها محمّد من العبريّة واستُعملت دون أنْ يُقصد منها معنىً خاص)(٢) .
وتحت مادّة(بسم الله) يقول(كارادي فو B Carrde Vaux ): (وتساءل بعض المستشرقين عمّا إذا كانت صيغتا الرحمن والرحيم من أسماء آلهة الجاهليّة، التي بقيَت إلى جانب اسم الله، ثمّ أصبحتا مجرّد صفات)(٣) .
وتحت مادّة(الأنصار) يقول(ركندوف Reckendorf ): (ويظهر أنّ محمّداً استغلّ التشابه الموجود بين لفظ أنصار ونصارى فجعل عيسى يطلق على الحواريّين(أنصار الله) (سورة آل عمران، آية ٥٢، سورة الصف، آية ١٤)(٤) .
وتحت مادّة(بَعْل) يقول(ماكدونالد D. B Macdonald ): (ولا يزال بين كلمة(بَعْل) التي تدلّ على إله وبين(بَعِلَ) معناها دهِش أو فَرِق ومشتقّاتها صلةٌ ضئيلة، وليس لهذين الاشتقاقين الآن وجود... ودخلت [بَعل] إلى العربيّة تفسيراً لآيةٍ في القرآن، وقد أشار القرآن (سورة الصافّات، الآيات ١٢٣ - ١٣٢) إلى قصّة إلياس، وقال على لسانه: ( أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ) ، ومن المرجّح أنّ محمّداً قصَدَ بـ (بَعْل)(بَعَل) كما سمعها في قصّة من قصص التوراة (سِفر الملوك الأوّل، الإصحاح ١٨)(٥) .
____________________
(١) المصدر السابق.
(٢) المصدر السابق: ٥٦٤.
(٣) المصدر السابق ٣: ٦٤.
(٤) المصدر السابق ٣: ٥٣.
(٥) المصدر السابق ٣: ٦٩٤.
أمّا(بول F. Buhl ) فيقول تحت مادّة(سورة): (أمّا مِن أين أتى النبيّ بهذه الكلمة؟، فأمرٌ لا يزال غيرُ ثابت على الرغم من المحاولات التي بُذلت لتتبّع أصلها. ويذهب(نولدكه) إلى أنّ(سورة) هي الكلمة العبريّة الحديثة(شورا) ومعناها الترتيب أو السلسلة، ولو قد أمكن تفسيرها بأنّها(السطر) لِما قادنا ذلك إلى المعنى الأصلي للكلمة...)(١) .
إنَّ جميع مفردات هذه الشُبهة تعود في الحقيقة إلى جَهل المستشرقين، أو تجاهلهم لمعاني ألفاظٍ عربيّة وردَت في القرآن الكريم، فافترضوا، بعد تشكيل مقدّمةٍ باطلة من معانٍ وهميّة ادّعوها لتلك الألفاظ، أنّها استُعيرت من صلوات النصارى مرّة، أو أُخِذَت من العبريّة مرةً أُخرى، أو أنّها من الأسماء الجاهليّة ثالثة، أو استقيت من قصص التوراة رابعة، أو أنّها ألفاظ شديدة الغموض، أو لا معنى لها خامسة، وهكذا... ويبقى الهدف الحقيقي وراء هذه التمحّلات هو إنكار الوحي الإلهي للرسول محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، الذي سنُعالج أمره في الشبهة اللاحقة إنْ شاء الله، كما يرد عليها ما أوردناه على(ر. پاريه) تحت مادّة(أمّة).
أمّا أهمّ الألفاظ التي أنكروا الأصالة العربيّة لبعضها، وجهلوا أو تجاهلوا استعمالها في معانيها العربيّة الأصيلة في آيات القرآن الكريم، فهي كالآتي حسب تسلسل ورودها في الشبهة السالفة الذكر:
١ - قُدّوس: على وزن فُعُّول من القُدْس. وفي التهذيب: القُدْسُ تنزيه الله تعالى، والقدّوس: من أسماء الله تعالى، قال الأزهري: القدّوس هو الطاهر المُنزّه عن العيوب والنقائص، وقال ابن الكلبي: القدّوس، وحكى ابن الأعرابي: والمقدّس المبارك.
____________________
(١) المصدر السابق ١٢: ٣٥٨.
ويُقال أرضٌ مقدّسة أي مباركة، وهو قول العجاج:
قد عَلِمَ القَدُّوس مولى القُدْس * أَنَّ أبا العبّاس أولى نفسِ
بِمَعْدن المُلْك القديم الكرْسي
يعني بالقدّوس هنا الله سبحانه وتعالى وبالقُدْس الأرض المباركة(١) .
وقد طابق قول المفسّرين المعنى اللغوي في تفسير كلمة(قُدّوس) ، فذكر الطباطبائي في تفسير الميزان أنّ القدوس مبالغة في القُدس وهو النزاهة والطهارة(٢) .
وقال الطوسي في تفسير التبيان:(القُدّوس) معناه المُطهَّر فتطهر صفاته عن أنْ يدخل فيها صفةُ نقص(٣) .
فكيف يدّعي(ماكدونالد) عدم معرفة المعنى المراد من هذه الكلمة في القرآن الكريم؟!
٢ - السَّلام: ورد في معنى السَّلام والسلامة: البراءة. وتسلّمَ منه: تبَرّأ. وقال ابن الأعرابي: السلامة العافية. والتسليم: مشتقٌّ من السلام اسم الله تعالى، لسلامته من العيب والنقص. والسَّلامُ: البراءة من العيوب في قول أُميّة:
سَلامك رَبَّنا في كلّ فجرٍ***بريئاً ما تعنّتكَ الذُّمُومُ
والذُّموم: العيوب، أي ما تَلزقُ بك ولا تُنسب اليك(٤) .
وهنا أيضاً جاء قول المفسّرين مطابقاً للمعنى اللغوي، مِن أنّ السلام هو الذي يسْلَم عباده من ظلمه(٥) ، وأنّ السلام من يلاقيك بالسلامة والعافية من غير
____________________
(١) لسان العرب: مادّة (قدس). والقاموس المحيط مادّة (قدس).
(٢) السيّد الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن ١٩: ٢٥٦.
(٣) الطوسي، التبيان ٩: ٥٧٣.
(٤) لسان العرب: مادّة (سلم). والقاموس المحيط: مادّة (سلم).
(٥) الطوسي، التبيان ٩: ٥٧٣.
شرٍّ وضرّ(١) .
فأين شدّة الغموض الذي يدّعيه(ماكدونالد) في المعنى الواضح لهذه الكلمة القرآنيّة؟!
٣ - النُّور: جاء في قواميس اللغة أنّ مِن أسماء الله تعالى النور؛ قال ابن الأثير: هو الذي يُبصِر بنوره ذو العَماية، ويَرْشدُ بهُداه ذو الغَوايَةِ، وقيل: هو الظاهر الذي به كلّ ظُهور، والظاهر في نفسه المُظْهِر لغيره يُسمّى نوراً.
قال أبو منصور: والنور من صِفات الله عزّ وجل، قال عزّ وجلّ: ( اللّهُ نُورُ السّماوَاتِ وَالأَرْضِ ) (٢) .
وقد ورد في تفسير هذه الآية الكريمة: إنّ النور معروف وهو ظاهرٌ مكشوف لنا بنفس ذاته، فهو الظاهر بذاته المُظهِر لغيره من المحسوسات للبصر، هذا أوّل ما وضع عليه لفظ النور، ثمّ عُمّم لكلّ ما ينكشف به شيء من المحسوسات على نحو الاستعارة أو الحقيقة الثانية، فعُدَّ كل من الحواسّ نوراً أو ذا نور يُظهِر به محسوساته كالسمع والشم والذوق واللمس، ثمّ عُمِّم لغير المحسوس فعدّ العقل نوراً يظهر به المعقولات.
كلّ ذلك بتحليل معنى النور المُبصِر إلى الظاهر بذاته المُظهِر لغيره... فقد تحصّل أنّ المراد بالنور في الآية الكريمة، الذي يستنير به كلُّ شيء وهو مساوٍ لوجود كلّ شيء وظهوره في نفسه ولغيره وهي الرحمة العامّة(٣) .
بعد هذا البيان كيف يدّعي(ماكدونالد) صعوبة معرفة المقصود من وصف الله تعالى بالنور؟!
٤ - العدل: ما قام في النفوس أنّه مستقيم، وهو ضدّ الجور. وفي أسماء الله سبحانه: العَدْل، هو الذي لا يَميلُ به الهوى فيجور في الحكم، وهو في الأصل صدر
____________________
(١) السيّد الطباطبائي في تفسير القرآن ١٩: ٢٥٦.
(٢) لسان العرب: مادّة (نور).
(٣) السيّد الطباطبائي، الميزان ١٥: ١٢٢.
سُمِّي به فوُضِعَ موضع العادل، وهو أبلغ منه لأنّه جُعِلَ المُسَمّى نفسه عَدلاً(١) .
وكلمة العدل وإنْ لم ترد كصفة أو اسم من أسماء الله سبحانه في القرآن الكريم، إلاّ أنّها جاءت كذلك في حديث الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم)(٢) .
٥ - البارئ: من برأ، وهي من أسماء الله عز وجلّ، والله البارئ: الذي خَلَقَ لا عن مثال(٣) . وبهذا المعنى جاءت في الآية الكريمة: ( هُوَ اللّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوّرُ ) أي المُحدِث المُنشئ للأشياء ممتازاً بعضها عن بعض(٤) .
فكلمة البارئ لفظٌ عربيٌّ أصيل استعمل في المعنى الخاص الذي أشرنا إليه، خلافاً لما ادّعاه(ماكدونالد) من أنّها استقيت من العبريّة ولم يقصد من استعمالها معنىً خاصّاً.
٦ - بَعْل: يُقال للرجل، هو بَعْلُ المرأة، ويُقال للمرأة، هي بَعْلُه وبَعْلتُه. وباعَلت المرأةُ: اتّخذت بعلاً، وباعل القوم قوماً آخرين مُباعَلة وبِعالاً: تزوّج بعضهم إلى بعض، والأنثى بَعْل وبَعْلة مثل زوج وزوجة؛ قال الراجز:
شَرُّ قرينٍ للكبير بَعلتُه * تُولغ كلباً سُؤرَه أو تكْفِتُه
وبَعَل يَبْعَل بُعولة وهو بَعْل: صار بَعْلاً وقال: يا رُبَّ بَعْل ساء ما كان بَعَل.
وبَعْلُ الشيء: رَبُّه ومالكهُ. وفي حديث الإيمان: وإنْ تَلِدَ الأمة بَعْلَها؛ المراد بالبعل ههنا المالك يعني كثرة السبي والتسرّي، فإذا استولد المسلم جاريةً كان ولدها بمنزلة ربّها.
وبَعْلٌ والبَعْل جميعاً: صَنَم، سُمّي بذلك لعبادتهم إيّاه كأنّه ربّهم. وقوله
____________________
(١) لسان العرب: مادّة (عدل). والقاموس المحيط: مادّة (عدل).
(٢) راجع: بحار الأنوار ٢: ٢٣٨ - ٢٣٩.
(٣) لسان العرب: مادّة (برأ). والقاموس المحيط: مادّة (برأ).
(٤) السيّد الطباطبائي، الميزان ١٩: ٢٥٧. والطوسي، التبيان ٩: ٥٧٤.
عز وجلّ: ( أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ) يُقال: أنا بَعْلُ هذا الشيء أي رَبُّه ومالكه، كأنّه يقول: أتدعون ربّاً سِوى الله؟
ورُوي عن ابن عبّاس: إنّ ضالَّةً أُنشدَت فجاء صاحبها فقال: أنا بعلُها، يُريدُ ربّها، فقال ابن عبّاس: هو من قوله أتدعون بعلاً أي رَبّاً. وورد أنّ ابن عبّاس مرَّ برجُلين يختصمان في ناقة وأحدهما يقول: أنا والله بعلُها، أي مالِكُها وربّها. وقولهم: مَنْ بَعلُ هذه الناقة؟ أي مَنْ رَبُّها وصاحبها(١) .
وجاء في كتب التفسير ما يُطابق المعاني اللغويّة التي ذكرناها، منها في تفسير الآية ( أَتَدْعُونَ بَعْلاً... ) ، قال الحسن والضحّاك وابن زيد: المراد بالبعل - ههنا - صنم كانوا يعبدونه، والبعل في لغةِ أهل اليمن هو الربّ، يقولون: مَنْ بَعْل هذا الثوب أي مَنْ ربّه - وهو قول عِكرمة ومجاهد وقتادة والسدّي - ويقولون: هو بَعل هذه الدابّة أي ربّها(٢) .
وعليه فكيف يدّعي(ما كدونالد) أنّ هذه الكلمة دخلت إلى العربيّة تفسيراً لآيةٍ في القرآن الكريم؟
٧ - سورة. السورة: المَنْزِلَة، والجمع سُوَرٌ، والسُّوَرةُ من البناء: ما حَسُنَ وطال. قال الجوهري: والسُّوْرُ جمع سُورَة مثل بُسْرَة وبُسْرٍ، وهي كل منزلة من البناء؛ ومنه سُورَة القرآن لأنّها منزلةٌ بعد منزلة مقطوعة عن الأخرى، والجمع سُوَرٌ بفتح الواو؛ قال الراعي:
هُنَّ الحرائرُ لا رَبّاتُ أَخْمِرَةٍ * سُودُ المَحاجِرِ لا يَقْرَأْنَ بالسُّوَرِ
وقال ابن سيّده: سُمّيت السُّورَةُ من القرآن سُورَةً لأنّها درجة إلى غيرها، وروى الأزهري بسنده عن أبي الهيثم قال: أمّا سورة القرآن فإنّ الله جلَّ ثناؤه
____________________
(١) لسان العرب مادّة (بعل). والقاموس المحيط: مادّة (بعل).
(٢) الطوسي، التبيان ٨: ٥٢٤ - ٥٢٥.
جعلها سُوَراً مثل غُرْفَةٍ وغُرَفٍ ورُتْبَةٍ ورُتَبٍ وزُلْفَةٍ وزُلَفٍ(١) .
بعد هذا البيان للمعنى اللغوي الأصل لكلمة (سورة) في اللغة العربيّة واستعمالها بهذا المعنى في القرآن الكريم، كيف يوجّه(بول) استفهامه عن مصدر هذه الكلمة وأصالتها؟ وكيف يدّعي(نولدكه) أنّها عبارة عن الكلمة العبريّة الحديثة(شورا)؟
ادّعاء النبيّ محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وابتكاره واصطناعه وتأثره بمَن حوله
وهذه الشبهة تعني بعبارة أُخرى، أنّه ليس وراء محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وحيٌ إلهي ولا تنزيل سماوي. فمثلاً تصوّر بعث النبيّ لجيش أُسامة على أنّها لأجل الثأر لأبيه زيد، وليس لها بُعد رسالي كما أُعطيَت إليه فيما بعد، وتجد ذلك تحت مادّة(أسامة) حيث يقول( V. Vacca ) : (بعث النبيّ أسامة على رأس جيش ليثأر لأبيه زيد الذي قُتِل في غزوة مؤتة. وبالرغم من الطعن بحداثة سنّه...)(٢) .
وتصوّر التشريعات الإسلاميّة على أنّها بدوافع ماديّة كان النبيّ محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يخضع لها، منها ما جاء تحت مادّة(أُصول) والتي يقول فيها(يوسف شاخت Joseph Schacht ) : (.. ولم يكن قصد محمّد خلق نظام يضبط به حياة أتباعه، أو وضع أُصول هذا النظام على الأقل، بل ظل القانون العرفي العربي القديم الذي تضمّن كثيراً من العناصر الدخيلة من روميّة إقليمية وبابلية ويمنيّة، يسير في الإسلام سيره الطبيعي، ودخلت عليه بعض التغييرات لتلائم بينه وبين الظروف الإقليميّة للبدو وأهل مكّة وهي مدينة تجاريّة، وأهل المدينة وهي مركز زراعي، وكان همُّ محمّد في
____________________
(١) لسان العرب: مادّة (سور). والقاموس المحيط: مادّة (سور).
(٢) دائرة المعارف الإسلاميّة ٢: ٧٧.
التشريع قاصراً على تصحيح بعض المسائل مدفوعاً إلى ذلك باعتبارات دينيّة؛ وذلك لأنّ الأحكام التي تمسّ الحياة الاجتماعيّة تقوم أيضاً على أساس ديني. وفي مثل هذه المسائل كانت الحوادث الخارجيّة هي الدافع إلى معالجة أكثرها)(١) .
وأنّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كان يبتكر ويقع تأثير عوامل مختلفة، منّها ما قاله(ماكدونالد D. B. Macdonald ) تحت مادّة(الله) (هـ - صلة الله بالإنسان): (... وكان محمّد في وقت ما يستعمل صفة (الرحمن) كاسم علم مرادف للكلمة(الله). واعتبر أهل مكّة ذلك من مبتكراته (انظر خبر صلح الحديبيّة وما جاء فيه من أنّ أهل مكّة رفضوا الصيغة التي تضمّنت الرحمن الرحيم، وتمسّكوا بالصيغة المكيّة القديمة(باسمك اللهم) ... ويظهر أنّ محمّداً قد أخذ هذه الصيغة عن جنوبي بلاد العرب)(٢) .
وتحت مادّة(أهل الكتاب) يقول(جولد صيهر Gold Ziher ) : (يسمّي محمّد اليهود والنصارى بهذا الاسم تمييزاً لهم عن عبَدة الأوثان... على أنّه رغم نزعة التعصّب التي كان يعبّر عنها بعبارات شديدة...)(٣) .
وتحت مادّة(جبرائيل) يقول(جولد سيهر Gold Ziher ) : (يسمّي محمّد اليهود والنصارى بهذا الاسم تمييزاً لهم عن عَبَدة الأوثان... على أنّه رغم نزعة التعصّب التي كان يعبّر عنها بعبارات شديدة...)(٣) .
وتحت مادّة(جبرائيل) يقول(كارادي فو Carrade Vaux ) : (ولجبرائيل شأنٌ هام في القرآن. وقد اصطنع النبيّ القصّة التي تقول بأنّ هذا الرسول السماوي يتحدّث إلى الأنبياء، واعتقد أنّه تلقّى رسالته ووحيه منه)(٤) .
ويقول أيضاً تحت مادّة(الجنّة) : (وقد ذُكرت مرّة واحدة في القرآن بالاسم الفارسي(فردوس) ... وقد عرف أنّ فكرة محمّد عن الجنّة مادّة حسيّة، وقد
____________________
(١) دائرة المعارف الإسلاميّة ٢: ٢٧٤ - ٢٧٥.
(٢) المصدر السابق ٢: ٥٦٥ - ٥٦٦.
(٣) المصدر السابق ٣: ١٠٦ - ١٠٧.
(٤) المصدر السابق ٦: ٢٧٦.
صُوّرت هذه الفكرة في سور كثيرة تتّصل بالفترة الأولى من دعوته، مثال ذلك (سورة محمّد، الآيات ١٦، ١٧)(١) .
ويُحاول الطعن في بلاغة القرآن جهلاً منه بأُصولها فيقول تحت نفس المادّة: (وفي سورة الرحمن، الآية ٥٥، وهي السورة التي صيغت في قالب أُنشودة لها لازمة، يتحدّث محمّد عن الجنّتين... وهو يذكر في السورة نفسها (الآيات ١٦ - ١٩) المشرقين والمغربين والبحرين. وليس تفسير هذه الإثنينيّة يسيراً إلاّ إذا كانت من أجل البحرين، وقد يُقال إنّ النبيّ قد التزم في هذا المقام صيغة المثنى لأنّها أوقع في السمع)(٢) .
وتحت مادّة(جهنّم) يقول(كارادي فو B Carrade Vaux ): (ولم يكن لدى النبيّ محمّد إلاّ فكرة أوليّة عن بناء جهنّم، فهو يتحدّث عن أبوابها ويحدّد عددها بسبعة (سورة لقمان، الآية ٧١، سورة الحجر، الآيتان ٤٣، ٤٤)(٣) .
وتحت مادّة(الحديبيّة) يقول(لامنس H Lammen ) : (ولم يستطع النبيّ أنْ يعدَّ نفسه قابضاً على ناصية الحال، إلاّ في الشهور الأخيرة من العام السادس للهجرة، بعد أنْ قضى على العشائر اليهوديّة وأذلّ المنافقين في المدينة، ومن ثمّ رأى أنّ الوقت قد حان للتظاهر ضدّ مكّة ردّاً على حصار الخندق، وهو الحصار الذي حاولته قريش، وقد اتّخذ النبيّ كلّ الأهبة لهذا التظاهر بفضل السياسة التي التزمها، ولم يحد عنها، فقد دأب على تركيز اهتمام قومه بمكّة أم البلاد، فكان تغييره للقبلة واصطناعه لأُسطورة إبراهيم، وتصويره بأنّه باني الكعبة، وفرضه الحجّ وإيجابه في ذلك الوقت على كافّة المسلمين، يخدم هذا الغرض دون سواه. ويبدو أنّ
____________________
(١) المصدر السابق ٧: ١٤٠ - ١٤١.
(٢) المصدر السابق ٧: ١٤٢ - ١٤٣.
(٣) المصدر السابق ٧: ١٩٧.
النبيّ فكّر أوّل الأمر في القيام بمظاهرة عسكريّة، فقد كان المفروض أنْ يسير في عدد يتفاوت بين ١٤٠٠ و١٦٠٠ من الرجال المسلمين، ولكنّه عدّل خطته وأعلن أنّه انتوى العمرة، وما كان الهدي الذي أخذه معه إلاّ استكمالاً للخدعة)(١) .
وتحت مادّة(سارق) يقول(هيفيننك Heffening ) : (السرقة وجزاؤها قطع اليد بنص القرآن (سورة المائدة، الآية ٣٨)، وكان هذا الجزاء من ابتكار الرسول، إلاّ أنّه ورد في أدب الأوائل أنّ وليد بن المغيرة ابتدعه أيّام الجاهلية، وقد يكون هذا النوع من العقوبة من أصل فارسي)(٢) .
وتحت مادّة(السفينة) يقول(كندرمان H Kindermann ) : (والشيء الذي أثار هذه المسألة في بادئ الأمر، هي الأوصاف التي ذكرها القرآن عن البحر. فقد تساءل(بار تولد W. Barthold ) بحقٍّ، كيف تأتّت للنبيّ محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) هذه الصوَر الواضحة عن البحر وعواصفه ومن أين استقاها)(٣) .
ويستمر تحت نفس المادّة قائلاً: (على أنّلامنس يعترف بأنّ الإشارات الكثيرة في القرآن والسيرة إلى الملاحة تُوحي بأنّ العرب كانوا على دراية وثيقةٍ بالبحر...)(٤) .
وتحت مادّة(شيطان) يقول(ترتون A. S Tritton ): (وكلمة شيطان شائعة في القرآن، ولكنّها لا ترد في سور العهد المكّي إلاّ مرّة منكّرة بصيغة المفرد فحسب، ولم ترد في صيغتها المحدّدة إلاّ في العهد الثاني، موحيةً أنّ النبيّ قد وجد أو تذكّر فكرة أُخرى عن الشيطان)(٥) .
____________________
(١) المصدر السابق ٧: ٣٠٨.
(٢) المصدر السابق ١١: ٤١.
(٣) المصدر السابق ١١: ٤٥٧.
(٤) المصدر السابق ١١: ٤٥٨.
(٥) المصدر السابق ١٤: ٤٧.
وتحت مادّة(صالح) يقول(بول Fr. Buhl ): (... ولكنّنا لا نستطيع أنْ نتحقّق من المصدر الذي استقى منه محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) اسم صالح وقصّة الناقة)(١) .
وعن دعوى وقوع النبيّ محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) تحت تأثير عوامل ماديّة مختلفة عند تشريعه للأحكام أو اتّخاذه للقرارات يقول(شاخت J. Schaht ): ( أمّا فيما يتعلّق بالمصادر الماديّة للشريعة الإسلاميّة، فإنّ عناصر كثيرة مختلفة جدّاً في أصلها (من آراءٍ عربيّةٍ قديمة وبدويّة: قانون التعامل بمدينة مكّة التي كانت مدينة تجاريّة، وقانون الملكيّة في واحة المدينة، والقانون العرفي الذي كان في البلاد المفتوحة، وهو قانون روماني إقليمي إلى حدٍّ ما، وقانون هندي) قد احتفظ بها الاسلام وأخذ بها من غير تحرّج، لكنها بعد ذلك أُخضعت لذلك التقييم الديني الذي شمل كل شيء وأنتج من جانبه أيضاً عدداً كبيراً من المبتكرات الفقهية) (٢) .
وتحت مادّة (زيد بن حارثة) يقول(فكا V. Vacca ): (وكان زيد يصغر محمّداً بنحو عشر سنوات، وهو من السابقين إلى الإسلام، إنْ لم يكن أوّلهم جميعاً، وزيد ينحدر من قبيلةٍ كانت تضرب قرب دومة الجندل، وكان عدد المُعتنقين النصرانيّة هناك كثيراً، كما كان أثر اليهوديّة واضحاً، وربما كان أثر زيد في تطوّر تفكير النبيّ كبيراً)(٣) .
ويضيف(فنسنك) إلى تأثير العوامل الماديّة المختلفة على النبيّ محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في تشريعه للأحكام واتّخاذه للقرارات أنّه كان يقع تحت طائلة الخدعة، فيقول تحت مادّة(الحج) : (وقد ثار اهتمام النبيّ بالحجّ أوّل مرّة في المدينة، ويرجع اهتمامه إلى عدّة أسباب بيّنها Mekkandns في كتابه Shouck Hargrnonye Chefeest ،
____________________
(١) المصدر السابق ١٤: ١٠٧.
(٢) المصدر السابق ١٤: ٢٤٦.
(٣) المصدر الساق ١١: ١٠.
فقد دعاه نجاحه الباهر في غزوة بدر إلى التفكير في فتح مكّة، وطبيعي أنّ التجهّز لهذا الفتح يكون أكثر توفيقاً إذا أثار النبيّ اهتمام صحابته بالأمور الدينيّة والدنيويّة جميعاً، فقد خدع النبيّ فيما كان يعقده من آمال على جماعة اليهود بالمدينة، وأدّت خلافاته معهم إلى قيام شِقاق ديني بينه وبينهم لم يكن عنه محيص، والى هذا العهد يرد أصل نظريّة دين إبراهيم)(١) .
وعن دعوى أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كان يقع في أخطاءٍ في مواقفه، وإبهامٍ في آرائه يقول(بول Fr. Buhl ) تحت مادّة(تحريف): (... والذي حدا بالمسلمين إلى الاشتغال بهذه الفكرة [التحريف] هو ما جاء بالقرآن من آيات، اتّهم فيها محمّد اليهود بتغيير ما أُنزل إليهم من كتب وبخاصّة(التوراة) مستعملاً التعبير(حرّفوا) (انظر مادّة القرآن).
وكان هذا الاتّهام في الواقع الطريقة الوحيدة لإخراج محمّد من مأزقٍ خطير، حين احتكّ في المدينة باليهود. فقد سعى مُنذ بدء رسالته إلى الحصول على تأييد أهل الكتاب يهوداً ونصارى؛ لاقتناعه بأنّ ما جاء في العَهدَين القديم والجديد يتّفق وما دعا إليه ممّا أُنزل عليه. ولكن عرضه للوقائع والشرائع التي جاءت في التوراة انطوى على إدراكٍ خاطئ، أثار عليه النقد والسخرية من جانب اليهود، فكان في نظرهم مبُطلاً. ولو أنّ ما استعرضه مِن الآراء كان مناقضاً لما أُنزل في الكتب المقدّسة القديمة لانتفت دعواه فيما يؤكّد مِن أنّه صاحب رسالة إلهيّة.
ولماّ كان اعتقاده أنّه رسول مُوحى إليه قويّاً لا يتزعزع لم يبقَ له غير مَخرجٍ واحد، ذلك أنّ اليهود عمدوا آثمين إلى تحريف الكتاب، وأنّه هو الذي أتى بالنص الصحيح؛ وهي دعوى جريئة يسّرها عليه أنّ هذه الكتب كانت مجهولة تماماً من أتباعه المؤمنين بصدق كلماته)(٢) .
____________________
(١) المصدر السابق ٧: ٣٠٢ - ٣٠٣.
(٢) المصدر السابق ٤: ٦٠٣.
ويضيف(بول) أيضاً تحت نفس المادّة: (وكان من نتيجة الطريقة المبهمة التي تحدّث بها محمّد في القرآن، عن تحريف الذين أُوتوا الكتاب، للتوراة والإنجيل أنْ ذهب علماء المسلمين مذاهب شتّى في تقديرهم للحقائق التي يقوم عليها هذا الاتّهام)(١) .
إنّ هذه الصياغة لمقولات الطعن بإلهيّة القرآن الكريم، ورسالة النبيّ محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بالإسلام تبرز لنا شبهة الإنكار الإلهي من خلال نماذج مفرداتها، التي سُقناها بصراحةٍ ووضوحٍ اشدّ من الصياغات السابقة. هذه الشبهة التي طالما بذل الكثير من المستشرقين وأمثالهم الجهد الكبير لتركيزها، وإطلاق الادعاءات وسَوق الأدلّة المتكلّفة لإثباتها. وعليه لابدّ لنا من أنْ نعقد بحثاً يَستوعب أبلغ ما يُمكن استلاله من جُملة مفردات أدلّتهم ودعواتهم المختلفة، التي ذكرت في المقام ليكون جواباً شاملاً وشافياً لجميع ما استقصيناه في هذه الصياغة والصياغات الأُخرى، أو لم نستقصِه من مفردات هذه الشبهة.
على أنّنا نجد أنّ منهج تناولهم لهذه الشبهة سلَك طريقين: الطريق الأوّل شبهات حول إعجاز القرآن، والطريق الثاني شبهات حول الوحي الإلهي للرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم). وللترابط الموضوعي الوثيق بين إعجاز القرآن والوحي الإلهي، سنتناول كلا هذين الطريقين بالبيان والرد كالآتي:
الطريق الأوّل: شبهات حول إعجاز القرآن الكريم: وتقوم هذه الشبهات على تأكيد بشريّة القرآن الكريم، ولكون الأُسلوب البلاغي للقرآن الكريم هو أحد الأسرار الأساسيّة لإثبات إعجازه وكونه وحياً إلهيّاً تحدّى البشر بأنْ يأتوا بمثله أو بعشرِ سوَر مثله بل بسورةٍ من مثله، وأنْ يدعوا مَن استطاعوا لذلك من
____________________
(١) المصدر السابق ٤: ٦٠٧.
دون الله إنْ كانوا صادقين، كان مطعنهم الأوّل موجّه لها لنفيها كأساس لذلك الإعجاز، وبتتبّعٍ تفصيليٍّ لمفردات هذه الشبهات يمكننا أنْ نقسّمها إلى قسمين: قسمُ يُحاول أنْ يبرز نقصاً أو خطأً في الأُسلوب البلاغي والمحتوى البياني للقرآن الكريم، ويُمكننا ملاحظة النماذج التي سُقناها سابقاً في هذا السياق، ولا نجد حاجةً لتتبّع المزيد من تفصيلات ذلك مفردةً بعد أُخرى والردّ عليها على ضوء القواعد العربيّة؛ لاستلزامه الإطالة من جهة، ولوجود من كفانا مؤنتها من جهة أُخرى(١) .
وقسمٌ آخر يُحاول أنْ يقيم الدليل على كون القرآن الكريم ليس بمعجزة في جانبه البلاغي لقدرة البشر على أنْ يأتوا بمثله وهذا القسم يشتمل على ما يلي:
الشبهة الأُولى: لمّا كانت الفصاحة والبلاغة القرآنيّة هي الأساس الأوّل في الإعجاز القرآني، ولمّا كان للعرب قواعد وأُسُس لتلك الفصاحة والبلاغة، تشكّل المقياس الرئيسي لديهم في تمييز ما هو بليغ وفصيح عن غيره، نجد أنّ بعض آيات القرآن الكريم تأتي خلافاً لتلك القواعد، أو لا تنطبق عليها تمام الانطباق، وعليه فإنّ القرآن الكريم يفتقد لنهج الفصاحة والبلاغة على الأُصول والقواعد العربيّة، فهو إذن ليس معجزاً ببلاغته.
وهنا سوف نكتفي بمناقشة أصل الفكرة والأساس الذي تقوم عليه هذه الشبهة، ونفي إمكان الاعتماد على هذا الأساس في الطعن بإعجاز القرآن فنقول:
١ - من خلال مراجعة تاريخ تأسيس قواعد اللغة العربيّة نجد أنّها ظهرت في زمن لاحق لنزول القرآن الكريم، وذلك عندما بدرت الحاجة إلى هذه القواعد خوفاً على اللغة العربيّة والنص القرآني الذي نزل على نسَقِها، من الاختلاط والضياع نتيجة اتّساع نطاق الدعوة الإسلاميّة، وامتداد رقعة دولتها، وتداخل
____________________
(١) راجع: الشيخ البلاغي، جواد، الهدى إلى دين المصطفى ١: ٣٣٠ فما فوق.
العرب بغيرهم من الشعوب الأعجميّة. ولم يُثبِت لنا التاريخ مبادرةً قبل مبادرةِ أبي الأسود الدؤلي تحت إشراف وإرشاد الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) أيّام خلافته.
على أنّ عمليّة وضع قواعد اللغة العربيّة كانت عبارة عن اكتشاف قام به بعض المهتمّين بشؤون اللغة العربيّة، على أساس ما كان يتّبعه العرب من أساليبٍ في البيان والنطق خلال كلامهم، وليس اختراعاً أوّليّاً من قِبل واضعي اللغة العربيّة. إذاً فكلام العربي الأصيل هو المصدر الأساسي في بناء القاعدة اللغويّة وصياغة تفصيلاتها، والقرآن الكريم كان في مقدّمة تلك المصادر المعبّرة عن الكلام العربي الأصيل، بل أوثقه وأبلغه على الإطلاق. لذا نجد أنّ جميع ما وصلنا من صياغات لقواعد اللغة العربيّة كانت تجعل القرآن الكريم مقياساً يحكم عليها بالصحّة أو الخطأ. وهذا هو الذي يجب أنْ ننحوه في لحاظ قواعد اللغة العربيّة وليس العكس.
٢ - يُضاف إلى ذلك أنّنا لم نجد ما بين نزول القرآن الكريم وحتّى اكتشاف وتدوين قواعد اللغة العربيّة أنّ التاريخ قد نقل لنا نقداً أو مطعناً في بلاغة القرآن وبيانه صدر من العرب المعاصرين لنزوله، وهم أهل البلاغة والفصاحة وذوو الخبرة والمعرفة المحيطة باللغة العربيّة، رغم شدّة عداء العديد منهم للرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وتكذيبهم لنزول الوحي الإلهي عليه بالقرآن الكريم.
بل نجدهم على العكس من ذلك، فقد أذعنوا لعظمة بلاغة القرآن الكريم واستسلموا لجمال بيانه الساحر، حتّى وصفه بعضهم لشدّة تأثّره به بأنّه سِحر، كنايةً عن مدى إيمانه بدقّة انسيابه البياني وانسياقه التعبيري، بشكلٍ يفوق مطلقاً ما هو مألوف لديهم من صيَغ البلاغة والبيان والتعبير.
الشبهة الثانية: إنّ المتميّزين والعارفين من أهل اللغة العربيّة قادرون على الإتيان بمثل الكلمات القرآنيّة أو بعضها. وهذا يعني أنّهم قادرون على الإتيان
بكلمات قرآنيّة؛ لأنّ حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، وهكذا يصبح من المعقول - بل المجزوم به - أنّ هذه القدرة يمكنها أنْ تمتد للإتيان بسورة أو بعدّة سور أو قل بمثل القرآن كلّه.
وفي معرض ردّ هذه الشبهة نقول: إنّ الإعجاز القرآني لا يكمن في كلمات متناثرة ومستقلّة بعضها عن البعض الآخر، إنّما هو في التركيب البياني بين الكلمات والأُسلوب الصياغي لها، وفي المحتوى والمضمون للمعاني والأفكار التي يُعبّر عنها ذلك التركيب والأسلوب في سياقات متعانقة الصلة منسجمة الحلقات.
فشتّان بين افتراض القدرة على الإتيان بكلمات متناثرة مهما كان عددها، وبين القدرة على نظمها على نَسَقِ الصياغات البلاغيّة في تركيب جمالي معبّر، ولا يحتاج هذا التمييز بين القدرتين إلى برهان، فهو أمرٌ وجداني يحسّه كلُّ عاقل ملتفت، حيثُ نجد أنّ الكثيرين قد يملكون قابليّة النطق بكلمات عربيّة عديدة ولكنهم لا يستطيعون أنْ ينظموا منها شعراً أو مقطوعة أدبيّة بليغة، أو يصوغوا منها خطاباً فصيحاً شأنَهم في ذلك شأن مَن يقوم بتوفير المواد الإنشائيّة وإنجاز أعمال محدودة وبسيطة منها، إلاّ أنّهم لا يستطيعون أنْ يشيّدوا أبنيةً ومشاريعَ هندسيّة دقيقة وضخمة رغم اشتمالها على تلك الأعمال المحدودة والبسيطة.
ونفس الكلام يأتي في المحتوى والمضمون، فمن نتصّور فيه القدرة على تقديم فكرة أو فكرتين، لا نتصوّر فيه القدرة على تقديم هذا الكم الكبير والمتناسق من الأفكار المتنوعة والمفاهيم المترابطة، خصوصاً إذا أخذنا بنظر الاعتبار نفس الظروف الموضوعيّة والذاتيّة التي نزل فيها القرآن الكريم والتحدّي الذي كان فيها.
الشبهة الثالثة: إنّ تحدّي القرآن للعرب عدّة مرّات قد اكتنفته عوامل وظروف منعت العرب آنذاك من معارضة القرآن وإظهار قدرتهم على الإتيان بمثله، فهم لم يعارضوه لأنّه معجز بل بسبب تلك العوامل والظروف المانعة. ويمكن
تحديد مرحلتين تاريخيّتين تميّزت كل مرحلة منهما بعوامل وظروف مانعة اختصّت بها وهما:
المرحلة الأولى: مرحلة التنزيل القرآني، حيث اتسمت بسيطرة المسلمين وسطوتهم على الواقع السياسي والاجتماعي للحاضرة العربيّة، ومحاربتهم لكل من يظهر العِداء للإسلام أو يتحدّاه، ممّا أبرز عوامل الخوف والرهبة في نفوس العرب المعاصرين، فأحجموا عن المعارضة والتحدّي للقرآن حفاظاً على أنفسهم وأموالهم من سطوة المسلمين.
المرحلة الثانية: مرحلة الخلافة الأُمويّة وممّا بعدها والتي أعقبت سلطة الخلفاء الأربعة الأُوّل. وقد عرف عن الأُمويّين أنّ خلافتهم لم تقم على أساس الحفاظ على الإسلام والالتزام به والدعوة إليه، فكان من الممكن إظهار المعارضة والتحدّي للقرآن، إلاّ أنّ الأُنس الذهني بمعانيه المتينة والألفة النفسيّة لألفاظه الجميلة جعلته من المرتكزات التي يتوارثونها جيلاً بعد آخر، فانصرفوا نفسيّاً وذهنيّاً عن التفكير بمعارضته وتحدّيه.
وردّ هذه الشبهة يكمن بملاحظة ما يلي:
١ - إنّ أوّل تحدٍّ بالقرآن الكريم للمشركين وطلب معارضته ولو بسورة مِن مثله جاء في سورتَي يونُس وهود، وهما مكيّتان، أي في أوّل مراحل الدعوة الإسلاميّة حين كان المسلمون مضطهدين ومطاردين، وكان المشركون في أوج قدرتهم، ومع كلّ ذلك لم يستطع أيٌّ من بلغائهم أن يقابل التحدّي بالمعارضة، مع العلم أنّ شوكة وسلطة المسلمين لم تظهر إلاّ بعد الهجرة إلى المدينة المنورة، وانحصرت بحدودها إلى إنْ تمَّ النصر بفتح مكّة أو آخر عهد النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم).
٢ - أنّ ظهور شوكة المسلمين وامتداد سلطانهم في الجزيرة العربيّة أواخر عصر النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وعصر الخلفاء الأربعة بعده، لم يلغِ وجود الكفّار، ولم يمنعهم من
إظهار كفرهم، خصوصاً إذا كان على مستوى الاحتجاج وقبول التحدّي بالمعارضة، والدليل على ذلك بقاء مجموعات عديدة من المشركين على دياناتهم كما هو شأن أهل الكتاب، وقد أقرّهم الإسلام على ذلك، ورعى مصالحهم الإنسانيّة والاجتماعيّة في ظلّ الدولة الإسلاميّة، شأنهم في ذلك شأن المسلمين، ومع كلّ ذلك لم نجد مَن تصدّى لمعارضة القرآن الكريم وادّعى القدرة على الإتيان بمثله، رغم أنّهم كانوا يحاولون الاجتهاد بمحاجَجات مختلفة أُخرى انتصاراً لدياناتهم على الإسلام.
٣ - لو سلّمنا أنّ فرضيّة وجود الخوف من معارضة القرآن الكريم بسبب السيطرة الإسلاميّة، إنّما منعت المشركين من إظهار هذه المعارضة والتجاهر بها، إلاّ أنّ معارضتهم السريّة كانت مُمكنة في إطار تجمّعاتهم الخاصّة، ولو ثبتت مثل هذه المعارضة لأظهروها في الفرَص السانحة، ولنُقلَت الينا كما نقلت نصوص أهل الكتاب الدينيّة فيما بعد وخصوصاً قصص العهديَن الخرافيّة المعارضة للقرآن الكريم.
٤ - من الطبيعي فيما عُهِد في الكلام البليغ وإنْ علت رتبته، أنّه يفقد رونقه ويتضاءل وقعه الجميل على الحسّ البشري كلّما تكرّر على المسامع، ويتحوّل بالتدريج إلى كلام عادي في شدّه وتحريكه البلاغي. فنرى الجديد من المقطوعات الأدبيّة أو القصائد البليغة يشدّ ويحرّك السامع أكثر من المكرّر وإنْ كان أقلّ منه بلاغةً وبياناً، ويتركّز هذا الحس كلّما تعدّد التكرار، ولو طبّقنا هذا الأمر على القرآن الكريم لوجدناه على العكس من ذلك، حيث يُجمِع أهل اللغة وأرباب البلاغة العربيّة أنّ حسّهم وتذوّقهم لبلاغة القرآن الكريم ومعانيه الجميلة المتناسقة تزداد شدّةً وحسناً كلّما أكثروا من قراءته وترديد آياته، ثمّ إنّنا لا نجد ذلك منحصراً بهم، بل يعمّ عادة الناطقين باللغة العربيّة على اختلاف مستوياتهم
وحسّهم الأدبي. وهذا يؤكّد الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم لا أنْ يكون نقصاً عليه.
ولو سلّمنا وافترضنا أنّ التكرار يُوجب الأُنس الذهني والأُلفة النفسيّة بالقرآن وبالتالي الانصراف عن معارضته، فهذا إنّما يتمّ عند المسلمين المؤمنين به والتالين له بشوقٍ وعقيدة، أمّا غيرهم مِن بُلغاء العرب وفصحائهم فليسوا كذلك، فهم مترّبصون به، وبإمكانهم قَبول التحدّي ومعارضته لو استطاعوا إلى ذلك سبيلاً.
الشبهة الرابعة: من خلال عقد مقارنة بين ما جاء في القرآن من قصص الأنبياء، وما جاء في كتب العهدين المتداولة(التوراة والإنجيل) نجد أنّ ما جاء في القرآن يختلف كثيراً في تفصيلات الحوادث ونسبتها إلى الأنبياء وأُممهم السالفة عمّا جاء في تلك الكتب. ولمّا كانت هذه الكتب ممّا يعترف القرآن بها أنّها من الوحي الإلهي، وكان هو وحيَاً إلهيّاً أيضاً فكيف يُخالفها في ذلك؟ وهل يُمكن أنْ يناقض الوحي الإلهي نفسه في الإخبار عن الأحداث والوقائع التاريخيّة؟
ثمّ إنّ القرآن جاء في مجتمعٍ وأُمّةٍ منفصلة عن تاريخ أنبياء تلك الكتب السماويّة وأُممهم، في حين أنّ تلك الكتب بَقِيَت متداولة جيلاً بعد آخر في أُمم هؤلاء الأنبياء، وهذا يعني أنّهم أدقّ معرفةً واطلاعاً بأوضاع هؤلاء الأنبياء وما جرى لهم مع آبائهم وأجدادهم، فيكون ذلك دليلاً على صِدق ما جاء في كتب العهدَين دون ما جاء في القرآن، وعليه يدلّ القرآن على صِدق نبوّة مَنْ جاء به.
ودفع هذه الشبهة يتمّ بلحاظ ما يلي:
١ - إنّ ادعاء بقاء كتب العهدَين متداولة، كما أُنزلت على أنبيائها في أُممهم جيلاً بعد آخر هو أوّل الكلام، إذ أنّ الصلة بين أجيال تلك الأمم لا تشكّل دليلاً على بقاء تلك الكتب سليمةً وبعيدةً عن يدِ التحريف والتزوير، خصوصاً إذا
عرفنا أنّ انفصالاً تاريخيّاً قد وقع بين تلك الأُمم وأنبيائهم، ممّا أفقد تلك الأُمم القدرة على الاحتفاظ بأُصول كتب العهدَين كما أُنزلت على هؤلاءِ الأنبياء، فكثُرت في نصوصها الاجتهادات وطالتْها يد التحريف والتزوير جيلاً بعد آخر، ويؤكّد القرآن الكريم هذه الحقيقة في معرض بيانه لواقع أُمم هؤلاء الأنبياء التي نزلت فيهم تلك الكتب(١) .
٢ - إنّ عقد المقارنة بين ما جاء في القرآن الكريم من قصص الأنبياء، وما جاء في كتب العهدَين المتداولة، والتعرّف على مواطن الاختلاف، يدعو بنفسه إلى تصديق القرآن الكريم دون كتب العهدَين وليس العكس؛ وذلك لأنّ تفاصيل قصص هؤلاء الأنبياء في القرآن الكريم، جاءت دقيقة ومتطابقة تمام الانطباق مع الأصول العقليّة والثوابت العقائديّة لواقع الأنبياء وصفاتهم الأساسيّة، في حين أنّنا نجد خلاف ذلك في التوراة والإنجيل، فهما يذكران العديد من الخرافات والأباطيل، وينسبان إلى أنبياء تلك الفترة مواقف لا تتّفق والصفات الواقعيّة للأنبياء وسلوكيّات لا تليق برُسُل الله وأُمنائه على أرضه ودينه(٢) . بل إنّها تتنافى مع صفات أصل الصلاح والإصلاح من عامّة الناس.
وعليه فإنّ العرض القرآني لقصص الأنبياء ووقائعهم، يظهر لنا جانباً مهمّاً من إعجاز القرآن الكريم؛ لانسجامه وائتلافه مع طبيعة الصفات الواقعيّة للأنبياء والرُسُل التي أرشدت إليها العقول وأقرّتها العقائد الدينيّة، ويؤكّد يقيننا بأنّ
____________________
(١) كقوله تعالى في سورة البقرة - الآية ٧٥ في تحريف بني إسرائيل للتوراة:(أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) .
وكذلك قوله تعالى في سورة المائدة - الآية ١٣:(فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ....) . وغيرهما من الآيات الشريفة.
(٢) للوقوف على نماذج من ذلك يُمكن الرجوع إلى كتاب الهدى إلى دين المصطفى للعلاّمة البلاغي، الجزء الثاني.
مصدرها الوحي الإلهي، وليس كتب العهدَين وأمثالها كما يدّعون.
هذه خلاصة لِما يرد على ما استلَلْناه من شُبهاتٍ مبثوثة، إجمالاً وتفصيلاً في طيّات دسِّ وتشويه المستشرقين، خصوصاً في دائرة المعارف الإسلاميّة، على أنّنا أجبْنا عن غير هذه الشُبهات سلفاً(١) .
الطريق الثاني: شبهات حول الوحي الإلهي للرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم): ويُمكن عموماً إرجاع هذه الشبهات إلى شبهةٍ أساسيّة، هي أنّ الوحي القرآني لا علاقة له بالسماء، إنّما هو وحي نفسي نابع من ذات محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم). على أنّ أُصول بعض هذه الشبهات ليس جديداً في موضوعه، فلطالما أثارها المعاندون من أهل الكتاب وأمثالهم بعد بعثة محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ونزول الوحي القرآني عليه، وما فعله بعض المستشرقين فيما بعد هو مجرد ترديد لتلك الشبهات وتطوير لها، وإضافة بعض الجديد عليها، وإخراجه بطابع البحث العلمي وشكلية الدراسة الموضوعية، ولقد أشار القرآن الكريم إلى مجموعة من هذه الشبهات في موارد مختلفة من آياته الكريمة، منها قوله تعالى: ( أَنّى لَهُمُ الذّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ * ثُمّ تَوَلّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلّمٌ مَجْنُونٌ ) (٢) ،
وقوله تعالى: ( وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذَا إِلاّ إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاؤُوا ظُلْماً وَزُوراً * وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ) (٣) ،
وقوله تعالى: ( وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنّهُمْ يَقُولُونَ إِنّمَا يُعَلّمُهُ بَشَرٌ لّسَانُ الّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيّ وَهذَا لِسَانٌ عَرَبِيّ مُبِينٌ ) (٤) ،
وقوله تعالى: ( بَلْ
____________________
(١) لمزيد من التفصيل يمكن مراجعة ما يلي:
أ - الشيخ البلاغي، محمّد جواد، الهدى إلى دين المصطفى، الجزأين الأوّل والثاني.
ب - السيّد الخوئي، أبو القاسم، البيان في تفسير القرآن.
ج - الشيخ معرفة، محمّد هادي، التمهيد في علوم القرآن الجزء الرابع.
(٢) الدخان: ١٣ - ١٤.
(٣) الفرقان: ٤ - ٥.
(٤) النحل: ١٠٣.
قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآَيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الأَوَّلُونَ ) (١) .
وفي الردّ على هذه الشبهات سوف نكتفي بمناقشة الشبهة الأساسيّة التي أشرنا إلى أنّها مرجع كلّ تلك الشبهات، ونمهّد لذلك ببيان معنى الوحي بشكلٍ واضح ليتسنّى لنا تحديد موضوع الشبهة بدقّةٍ أكثر.
ولتحديد معنى الوحي الإلهي اصطلاحاً نجده لا يخرج من جوهره عن المعنى اللغوي لكلمة الوحي، وهو الإعلام في خفاء(٢) . وهو أصلٌ يدلّ على إلقاء علمٍ في إخفاء أو غيره، وكلّ ما ألقيته إلى غيرك حتّى عَلِمَهُ فهو وحيٌ كيف كان(٣) .
فهو على ضوء ذلك مركّب ينحلّ إلى معرفةٍ تُدرك، وإدراكٌ عقليٌّ لها، وواسطة تنقلها، ومصدر تصدر عنه. وفي ما نحن فيه معنى الوحي الإلهي، الذي اختصّ به الله سبحانه أنبياءه ورُسُلَه من بني الإنسان، وكان القرآن الكريم أبرز مصاديقه، نجد أنّ شعور الإنسان المدرِك يختلف تجاه مصدر أفكاره وواسطة إيصالها إليه، ويُمكننا حصر أنحاء شعوره هذا في ثلاثة:
١ - شعوره بأنّ هذه المعرفة هي من بنات تفكيره الخاص، فهي نابعة من ذاته، وحصيلةَ جُهده الفكري الخاص وتعقّله الشخصي، وهذا ما يتعلّق عادةً بأفكارنا ومعارفنا العاديّة، ونحسه في حالات الإدراك الاعتياديّة، وهو يحصل لمطلق الإنسان العاقل، غاية الأمر أنّ المؤمن بالله سبحانه وتعالى يعتقد بأنّ جميع أفكاره تنتهي إلى الله الخالق الواهب المدبّر، المهيمن على جميع عوالم الوجود، بما في ذلك قدرتنا على التفكير والإدراك، فهو يعتقد بأنّ هذه الأفكار والمعارف العاديّة هي ثمرة تلك القدرة العقليّة التي وهبها الله له، ومكّنه من تفعيلها في ذات نفسه
____________________
(١) الأنبياء: ٥.
(٢) لسان العرب: مادّة وحي.
(٣) معجم مقاييس اللغة ٦: ٩٣.
فكانت واسطته في تحصيلها.
٢ - أنْ يشعر الإنسان بأنّ الفكرة أو المعرفة التي وعاها بإدراكه العقلي جاءته وخطرت إليه من خارج ذاته ونفسه، ويشعر بوضوحٍ كامل أنّها أُلقيت إليه من ذاتٍ عُليا منفصلةً عن ذاته تمام الانفصال، إلاّ أنّه لا يحسّ إحساساً واضحاً بالواسطة والطريقة، التي تحقّقت فيها عمليّة الإلقاء والإخطار في نفسه، من تلك الذات العليا، وهذا النحو من الشعور والإحساس تجاه الفكرة أو المعرفة المدرَكة هو الذي يحصل، فيما يُسمّى عند المؤمنين بالله سبحانه بحالة الإلهام الإلهي.
٣ - أنْ يقترن بالشعور الحسّي تجاه الفكرة أو المعرفة المُشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه، شعورٌ حسّيٌّ آخر بالواسطة والطريقة التي تقوم بعمليّة الإلقاء والإخطار، وتشكّل همزة الوصل بين الذات العليا المُلقية وذات الإنسان المُتلقّي، ويكون هذا الشعور والإحساس واضحاً جليّاً وضوح إحساسنا وإدراكنا للأشياء بحواسّنا العاديّة. وهذا ما يُسمّيه المؤمنون بالله سبحانه بالوحي الإلهي، وهذا الوحي مختص بالأنبياء، وهو الذي حدث في وحي القرآن الكريم إلى نبيّنا محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم).
وعليه فإنّ هناك ثلاث صور من الإدراك يُمكن أنْ تحصل للإنسان بشروطٍ معيّنة يختلف أحدها عن الآخر، فالإدراك نتيجة الموهبة غيره في الإلهام وغيرهما في الوحي.
شُبهة المستشرقين حول الوحي:
لقد أصبح واضحاً لدينا، بعد معالجة أهمّ الشبهات التي أثيرت حول إعجاز القرآن، أنّ القرآن ليس ظاهرةً بشريّة وليس من إبداعات محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، بل إنّه، ومن خلال جوانب إعجازه، التي تحدّى بها كلّ البشر، مرتبطٌ بالغيب المُطلق وهو
وحيٌ من الله سبحانه وتعالى إلى نبيّه.
وهنا تأتي شبهة المستشرقين ومَن تأثّر بهم حول مدى صدق الوحي الإلهي بالقرآن الكريم إلى محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فينكرون الوحي الإلهي إليه، ويرجعونه إلى نوعٍ من الإدراك الوهمي الذي جعل من محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يتخيّل، بسبب صفاء نفسه وصدقه وأمانته وتوقّده الذهني، أنّه يُوحى إليه من الله سبحانه، وهو في اعتقاد المستشرقين ليس إلاّ وحياً نفسيّاً يتفرّد به مَن يملك تلك الصفات، التي امتاز بها محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم).
ولإحكام صورة هذه الشبهة يذهب المستشرقون إلى تصوير العوامل التي أثّرت في محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وأذكت فطرته الزكيّة ودفعته للتفكير في إنقاذ قومه من ذلك الواقع المرير والعقائد الفاسدة، وتطهيرهم من الفواحش والمنكرات.
وكان أبلغ ما جاء به مُحرّرو دائرة المعارف الإسلاميّة، في تأسيس هذه الشبهة قد استقي ممّا كتبه(أميل درمنغام) الذي فصّل ما أجمله(مونتيه) في مقدّمات عشرة، وخلاصة ذلك أنّهم استعرضوا ما كان عليه العرب من الشرك بالله، وعبادة الأصنام والظلم الاجتماعي والفقر الاقتصادي، وارتكاب الفواحش والانغماس في الشهوات وأكل المال بالباطل، وتفشي المفاسد كشرب الخمر والزنى وغيرها من القبائح.
ثمّ يدعون أنّ محمّداً (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أدرك، كما أدرك أفراد آخرون من قومه بقوّة عقولهم الذاتيّة، هذا الواقع الفاسد، إلاّ أنّ تميّزه عن الآخرين بشدّة نقائه وصفائه الروحي والنفسي، وتوقّد ذهنه وقوّة عقله وطول تفكيره وتأمّله وسعيه الحثيث من أجل إنقاذ قومه ممّا هُم فيه من الشرك والظلم، وتزكيتهم من المفاسد والشهوات وتطهيرهم من الفواحش والمنكرات، هو الذي أوجد له مثل هذا الوحي النفسي.
ويذهب المستشرقون أكثر من ذلك في دسّهم وتشويههم، فيدّعون - كما أسلفنا بنماذج منه - أن محمداً قد استقى من اليهود والنصارى خلال لقاءاته بهم في أسفاره إلى الشام، أو ممّن كان منهم في مكّة الكثير من قصص الأنبياء والرسُل، وخصوصاً أنبياء بني إسرائيل ورسلهم، ولاعتقاده بأنّ البِدَع قد طالت العديد من المعارف والمعلومات التي حصل عليها من هؤلاء اليهود والنصارى، واندساس الكثير من الانحرافات والأفكار الوثنيّة فيها كالقول بأُلوهيّة المسيح وأُمّه، فقد رفض الكثير من تلك المعارف والمعلومات.
كما أنّه عرف من تلك اللقاءات أنّ بعض الأنبياء ومنهم نبيّ الله عيسى (عليه السلام)، قد بشّروا ببعثة نبيٍّ مثلهم من عرب الحجاز، فخلقت هذه المعرفة في نفس محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أملاً كبيراً ورجاءً شديداً في أنْ يكون ذلك النبيّ الموعود، وأنّ بعثته قد حان أوانها، فانقطع إلى مناجاة الله وعبادته، واختلى لذلك في غار حِراء سعياً منه إلى تحقيق هذا الأمل الذي استقطب كلّ وجوده.
وباستمراره في خلواته العباديّة هذه تأصّل إيمانه وقَوِيَ يقينه وتسامت نفسه، فتألّق تفكيره واشتدّ نور بصيرته، فاستشرف بعقله الكبير آياتٍ ودلائل وبيّنات ربّه في السماوات والأرض.
واهتدى إلى وحدانيّة الله سبحانه في الخلق والتدبير، فتأهّل بذلك لمهمّة دعوة الناس وهدايتهم الى الحقّ واليقين، والنور الذي اهتدى إليه.
وامتزج تفكيره وتأمّله بالمعاناة التي يعيشها في قومه والآمال التي تنشأ في نفسه، فارتكز لديه اليقين بأنّه هو النبيّ الموعود، الذي بشّر الأنبياء السابقون بأنّ الله سيبعثه لهداية الناس.
وتجلّت عقيدته هذه في الرؤى التي تكرّرت لديه في المنام وقوِيت الى الدرجة التي تحوّلت الى اعتقاد بأنّه قد بُعث نبيّاً لهذه الأُمّة وأنّ ملَكاً أخذ يتمثّل له
ويلقّنه الوحي في اليقظة كما يوحي له في المنام.
أمّا مصدر المعلومات التي نسجها له هذا الوحي، فهي مستقاة في الأصل ممّا حصل عليه من اليهود والنصارى، وأعمل فيه عقله وتفكيره، فاهتدى إلى التميّيز بين ما يصحّ منها وما لا يصح، كلّ ذلك كان يتجلّى له وكأنّه وحي الله له وخطابه إليه يأتيه بواسطة(الناموس الأكبر) ، الذي نزل على موسى بن عمران وعيسى بن مريم وغيرهما من الأنبياء (عليهم السلام).
إنّ مراجعة نقديةّ لهذه الدعوى(نظريّة الوحي النفسي) نجدها تتهافت في أدلّتها وتتداعى قوائمها، ولا تصمد أمام المناقشة العلميّة. ويمكننا الإجهاز عليها من جوانبٍ ثلاثة:
الجانب الأوّل: الأدلّة والوقائع التاريخيّة تناقض نظريّة الوحي النفسي.
وخلاصة هذا الجانب يُمكننا حصرها في ما يلي:
أ - إنّ أغلب الأدلّة التاريخيّة التي اتخذت مقدّمات للقول بالوحي النفسي وأُسّست النظريّة على أساسها، ليس لها واقع في التاريخ الصحيح المنقول إلينا، إنّما جاءت وفق منهجٍ معكوس، حيثُ افترضوا رؤيةً مسبقة تقول: إنّ الوحي القرآني ليس وحياً منفصلاً عن ذات محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، ثمّ ساقوا حوادثَ وأخباراً نسجتها خيالاتهم الخصبة أو اختلقتها ذهنيّات جهلهم المركّب في تأويل بعض الوقائع التاريخيّة، وتشويه حقيقتها بالدسّ والتحميل بما لا تتحمّل لتكتمل لديهم حلقات وأجزاء الصورة المفترضة.
ومن أمثلة ذلك: ادّعاؤهم أنّ خبر غلب الفرس وانتصارهم على الروم، وأنّ الروم سيغلبون الفرس بعد ذلك، الوارد في سورة مريم، قد سمِعه محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من نصارى الشام. وهذا ممّا تكذّبه الوقائع التاريخيّة المنقولة الينا، حيثُ إنّ غلَبَة الفرس على الروم كانت في سنة(٦١٠م)، أي بعد رحلة محمّد الأخيرة الى الشام
بأربع عشرة سنة وقبل بدء الوحي الإلهي بسنة، ثمّ إنّ التاريخ يحدّثنا أنّ إمبراطوريّة الروم آنذاك كانت مُتداعية الأركان خائرة القُوى، فطبيعة الأشياء ومنطق الظواهر يحكي لنا عدم قدرتهم على الظهور والانتصار على الفرس، حتّى إنّ أهل مكّة عندما سمعوا ما قرأه عليهم الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، من الخبر في القرآن الكريم هزئوا به.
ومن الأمثلة أيضاً افتراضهم أحاديثَ دينيّة معضلة وفلسفيّة معقّدة فيما زعموه من لقاء الراهب بُحيرى مع محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وهو بصحبة عمّه أبي طالب، ولم ينقل لنا التاريخ مثل هذه الأحاديث، ممّا يؤكّد لنا أنّهم نسجوا واختلقوا ذلك لدعم رؤيتهم المسبقة في الوحي النفسي.
ويدّعون أيضاً في مسألة إحاطة الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بأخبار عادٍ وثمود وتفاصيلها، أنّه حصل عليها وعرفها عند مروره بأرض الأحقاف، على أنّ التاريخ لم ينبئنا أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كان قد مرَّ بتلك الأرض، خصوصاً وأنّ هذه الأرض لا تقع على الطريق المتعارف لمرور القوافل التجاريّة.
ب - لو كان زعمهم أنّ النبيّ محمّداً (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قد تعلّم من نصارى الشام ومن غيرهم صحيحاً، لاحتجّ به المشركون وأعلنوه، ولَما وقعوا في الحيرة والتردّد مِن أمر الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ودعوته، خصوصاً وأنّهم كانوا يتتبّعون أخباره ويرصدون تحركّاته ومواقفه، ولم يتركوا شيئاً من سفراته ورحلاته وغيرها من شؤون حياته العامّة إلاّ وأحاطوا بها، فكيف تفوتهم مثل هذه اللقاءات والعلاقات المهمّة لو كانت واقعاً؟
رغم أنّهم بذلوا الكثير في سبيل اختلاق التهم وإطلاق الأباطيل والأراجيف حول الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ودعوته، كما في اتّهامهم إيّاه أنّه تعلّم وتلقّى ما يدّعيه وحياً مِن أشخاص تعرّف عليهم، كالحدّاد الرومي صانع السيوف في مكّة. هذه التهمة التي نزل في ردّها وتكذيبها قوله تعالى: ( وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا
يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ) (١) .
ج - لم ينقل لنا التاريخ أيّ شاهد على أن الرسول محمّداً (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كان يأمل أنْ يكون النبيّ المنتظر ويترقّب الوحي في أيّة لحظة... لينمو هذا الأمل - وفق زعمهم - ويتكامل في نفسه، ويشتدّ ترقّبه للوحي ويستحكم ليخلق ذلك الواقع النفسي المفترض. ونحن نعلم أنّ كتب السيرة النبويّة الشريفة قد نقلت لنا أدقّ الأحداث والوقائع واستقصّت تفصيلات الحياة الشخصيّة للرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، ولم تشر لنا من قريب أو بعيد الى مثل هذا الزعم.
د - إنّ من مفروضات هذه النظريّة أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، تدرّج في تكامله العقلي والنفسي ضمن مراحل طويلة مليئة بالمعاناة من واقع قومه الفاسد، والتفكير المتواصل بعقائدهم الباطلة في الشرك بالله وعبادة الأصنام، والتأمّل في طريقة إنقاذهم من ذلك ومن الظلم الاجتماعي الذي رزحوا فيه، وأنّه لم يعلن نبوّته إلاّ في مرحلة عُليا مِن هذا التكامل وتلك المعاناة وذلك التفكير..
فهو إذن في أعلى درجات الفهم والإدراك، لما يجب أنْ يطرحه من مفاهيم وأفكار ومناهج عن الكون وجميع جوانب الحياة والإنسان، وهذا يعني أنّ أُطروحة دعوته في خطواتها الأُولى ولحظاتها الأوليّة يجب أنْ تشتمل على تلك المفاهيم والأفكار والمناهج.. في حين أنّ التاريخ يؤكّد لنا خلاف ذلك. فالبداية تخلّلها اضطراب وخوف ثمّ جاءه الوحي بآيات التوحيد متدرّجاً في بيان أدلّته، واستئصال جذور الشرك وتسخيف عبادة الأوثان، والردّ على أباطيل المنحرفين والضالّين من أهل الأديان السابقة، مذكّراً بالعِبَر وضارباً الأمثال بسُنن الله في الماضين من الأنبياء والرسُل. ثمّ انقطع الوحي ثلاث سنين لم يحدّثنا التاريخ أنّ الرسول ادّعى شيئاً
____________________
(١) النحل: ١٠٣.
جديداً من الوحي فيها، ليعود بعد ذلك الانقطاع فيوحي للنبيّ الكريم آيات ربّه الأخرى.. ومن الواضح أن هذا يناقض القول بتكامل مفاهيم النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأفكاره واستعداده العقلي والنفسي لطرحها في أولى مراحل إعلان نبوّته.
الجانب الثاني: نظريّة الوحي النفسي تناقض محتوى الوحي القرآني:
وفي هذا الجانب يقف الناقد الموضوعي إزاء نظرية الوحي النفسي موقف التشكيك بل الرد والرفض، لأنه لا يستطيع التوفيق إطلاقا بين ما تفترضه هذه النظرية من مصادر في طبيعتها ومحدوديتها وبين السعة والشمولية التي اتسم بها المحتوى الداخلي للوحي القرآني.
ويمكننا توضيح ذلك من خلال ملاحظة الأُمور التالية:
أ - إنّ موقف الوحي القرآني من الأديان السماويّة السابقة، وخصوصاً الديانتَين اليهوديّة والمسيحيّة، له صورتان: الصورة الأُولى، هي التصديق بأصل هاتَين الديانتين، والإقرار بأنّ الله تعالى قد بعث رُسُلاً بهما مُبشّرين ومنذرين. والصورة الثانية، هي اتّخاذه موقع المهيمن عليهما جملةً وتفصيلاً، فهو حاكم على تشريعاتها نَسخاً وإمضاءً، ورقيباً على ما طرأ عليها من انحرافات، وما دُسَّ فيها من ضَلالات ليظهر الحقّ ويدحض الباطل.
وذلك في قوله تعالى:
( وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ... ) (١) ، وقوله تعالى: ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ *... مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ..... ) (٢)
____________________
(١) المائدة: ٤٨.
(٢) النساء: ٤٤ -٤٦.
وقوله أيضاً: ( فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ لَعَنّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظّاً مِمّا ذُكّرُوا بِهِ.... * وَمِنَ الّذِينَ قَالُوا إِنّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظّاً مِمّا ذُكّرُوا بِهِ ) (١) .
واتّصفت هذه الرقابة بالشموليّة والدقّة التامّة، فقد استوعبت كلّ المفاهيم والأحكام والوقائع التاريخيّة، وجعلت للصحيح منها مقياساً أظهرت فيه الحقّ وردّت الباطل. وهو مفاد قوله تعالى:
( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) (٢) .
فمع هذه الرقابة الشاملة والدقيقة، والتصريح القاطع بكلّ يقينٍ ورسوخٍ بجهل أهل الكتاب ونسيانهم وتحريفهم الكلِم وتبديله، كيف يُمكننا القبول بدعوى أخذ محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عن أهل الكتاب؟ وبماذا نفسّر هذا التتبّع الدقيق والشامل لتفاصيل ما اختلفوا فيه، أو خالفوا ما نزل عليهم من الدين الصحيح، والبيان المُحكم لِما هو الحقّ والصواب منه بلا تناقض ولا تخلّف ولا اختلافٍ فيه؟ وليس للمنطق جواب إلاّ التصديق بأنّ كلّ ذلك قد تلقّاه الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وحياً إلهيّاً، مصدّقا لما بين يديه من الكتب ومهيمناً عليه.
ب - لو كان ما يزعمون من الوحي النفسي صحيحاً وأنّ مصادره التي استقى منها الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) هما التوراة والإنجيل، لكان الأَولى أنْ يُجمل في كثير من الموارد أو يغض الطرف عنها أو عن بعضها، لئلاّ يقع مثل هذا التعارض والاصطدام بهما، إلاّ أنّنا نجد العكس من ذلك، فقد جاء محتوى الوحي القرآني بلسان التأكيد والإصرار على بيان الحقائق بكلّ قوّة، وإظهار مخالفته للتوراة والإنجيل في بعض الوقائع التاريخيّة بكلّ وضوح ودون أي تردّد أو إجمال. ومن
____________________
(١) المائدة: ١٣ - ١٤.
(٢) المائدة: ١٥ - ١٦.
نماذج ذلك ما في قصّة موسى، حيث يُخالف القرآن الكريم ما جاء في سِفر الخروج من أنّ التي كفلت موسى هي ابنة فرعون، في حين يؤكّد القرآن أنّها كانت امرأته في قوله تعالى:
( وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرّتُ عَيْنٍ لّي وَلَكَ لاَ تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنفَعَنَا أَوْ نَتّخِذَهُ وَلَداً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ) (١) ، وفي نموذج آخر نجد التوراة تذكر غرَق فرعون بإجمال وإبهام، في حين نجد القرآن الكريم يشير الى غرق فرعون، وكيّفيّته بشكلٍ دقيقٍ وواضح، بما في ذلك بيان مسألة نجاة بدَن فرعون من الغرق رغم موته وهلاكه، وكذلك بيان الحكمة من ذلك، وهو قوله تعالى:
( فَالْيَوْمَ نُنَجّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنّ كَثِيراً مِنَ النّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ) (٢) .
ومثال آخر هو عزو التوراة صنع العجل الذي عبده بنو إسرائيل الى هارون (عليه السلام)، في حين يصرّح القرآن خلاف ذلك ويعزوه الى السامري، ويثبت إنكار هارون (عليه السلام) عليهم في ذلك، ونفس الأمر يرد في قصّة ولادة مريم للمسيح (عليهما السلام)، وغيرها من القضايا.
وعليه فلا نتصوّر في محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، الذي يعترفون بحقّه أنّه الصادق الأمين الفطِن أنْ يأتي بمثل هذه التفاصيل ويُعارض بها التوراة والإنجيل، دون أنّ يكون ذلك قد تلقّاه من لَدُن العليم الخبير عن طريق وحيه الأمين، ويتحمّل الكثير من أذى أهل الكتاب في الثبات عليها وعدم مخالفتها.
ج - إنّ استيعاب الوحي القرآني في جانب كبير من محتواه الداخلي لتفاصيل التشريع الإسلامي بكلّ دقّةٍ وعمق، وبشموليّة وسِعَتْ كافّة مجالات الحياة المختلفة وجوانب الإنسان ووجوده، لا تجد فيما بينها إلاّ الانسجام التام والتناسق الفريد، ليس إلاّ برهاناً ساطعاً على تلقيه كل ذلك عن طريق الوحي
____________________
(١) القصص: ٩.
(٢) يونس: ٩٢.
الإلهي، ولا يُمكننا أنْ نتصوّر معه أنّ إنساناً كمحمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وهو الأُمّي الذي كان يعيش ذلك العصر المُظلم بالجهل والخرافات، والذي قضى أغلب أدوار حياته الرساليّة في خوضِ صراعٍ اجتماعيٍّ مرير، أنْ يقع له ما يزعمونه من الوحي النفسي، ويحقّق عن طريقه ذلك الكمال الإعجازي في مسائل التشريع الإسلامي.
الجانب الثالث: سُلوك النبيّ تجاه الوحي القرآني يأبى نظريّة الوحي النفسي:
قبل أنْ ندخل في تفاصيل طبيعة سُلوك النبيّ محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، تجاه الوحي القرآني الذي يكشف عن إدراكه الواضح للانفصام التام، بين ذاته المُتلقّية والذات الإلهيّة المُلقية مِن عليائها بواسطة الوحي، نُشير باختصار الى أنحاء هذا الوحي الرسالي الذي تلقّاه النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، والذي يثبت حقيقته وإدراكه الكامل له، وهي في قوله تعالى: ( وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلّمَهُ اللّهُ إِلاّ وَحْياً... ) ، أي إلهاماً وإلقاماً وإلقاءً في روعه يدركه المُوحَى إليه ويحسّه وكأنّما قد كُتِب في صفحة ضميره بوضوحٍ وجلاء، أو رؤيا في منام، وهذا هوالنحو الأوّل للوحي الرسالي.
والنحو الآخر في قوله تعالى: ( ..أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ.. ) ، أي يكلّمه تكليماً يسمع صوته وهو محتجبٌ عنه لعلوّه تعالى شأنه وكماله، وتدنّي المُوحَى إليه ونقصِه، وذلك بخلق الصوت المتضمّن للكلام في الفضاء المُحيط بالمخاطب فيخرق مسامعه، ويأتيه من كلّ مكان حوله، كما كلّم موسى (عليه السلام) وكلّم نبيّنا محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ليلة المعراج.
أمّاالنحو الثالث فهو في قوله تعالى: ( ..أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً.. ) ، أي ملكاً مِن الملائكة يتمثّل على شكل رجل: ( فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنّهُ عَلِيّ حَكِيمٌ * وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) .
وقد بيّن الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ذلك للمسلمين تكراراً وفي مناسبات عديدة، منها قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إشارةً الى الوحي القرآني:(أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرَس وهو أشدّه علي فينفصم عني وقد وعيت ما قال. وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول) .
أمّا طبيعة سُلوك النبيّ محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، الذي يأبى مقولة وحيه النفسي، ويعكس وعيه الكامل وإدراكه التام بالانفصال في الوحي القرآني بين الذات العُليا المُلقِية للخطاب وذاته الخاضعة المُتلقّية، فله حالات عديدة نشير الى ثلاث صور منها هي:
الصورة الأُولى: وهي التي يتمثّل سُلوك النبيّ محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فيها تجاه الوحي القرآني كعبدٍ ضعيف مفتقر الى الله تعالى، يتخضّع بين يَدَي ربّه، ويبتهل إليه، ويخشى أنْ يحول بينه وبين قلبه، فيستمدّ منه العون والهداية، ويطلب منه المغفرة والرحمة، ويتمثِل أوامره ونواهيه ويصدع بها، ويتلقّى منه بكلّ خشوع مختلف درجات العتاب وأنواعه.
ولقد طفحت آياتٌ قرآنيّة عديدة بوصف النبيّ الكريم (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، إنّه ذلك العبد المطيع الذي لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرّاً إلاّ بإذن ربّه، يخافه إنْ هو عصاه، ويرجو رحمته، ولا يخرج عن حدوده التي رسمها له، فهو لله وهو إليه يرجع، ولا حول ولا قوّة له إلاّ به سبحانه، فهو مُقِرٌّ بالعجز المطلق أمام أمر الله وإرادته، وليس بقادرٍ على أنْ يُبدّل حرفاً واحداً مِن القرآن الكريم.
ومِن أمثلة تلك الآيات الكريمة قوله تعالى: ( وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ * قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ) .
وقوله تعالى: ( قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ) .
ثُمّ تُؤكّد وتكرّر آيات قرآنيّة أُخرى الفارق بين صفات الذات الإلهيّة الملقيّة وصِفات الذات المحمّديّة المتلقّية من أنّه بشرٌ مثل سائر البشر، ليس عليه إلاّ البلاغ، ولا يملك خزائن الله ولا يعلم الغيب، ولا يزعم أنّه مَلَك، بل هو مخلوقٌ يتّبع ما يُوحى إليه من ربّه.
ومِن تلك الآيات قوله تعالى: ( قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ.. ) .
وقوله تعالى: ( قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ... ) .
ومن المعاني اللطيفة في البلاغة القرآنيّة هو مدلول عبارة (قل)، التي تُؤكّد على معنى المغايرة بين المُلقي والمتلقّي، وأنّ الخطاب الإلهي كان يُلقى على الرسول إلقاءً، وأنّه كان يُعلَّم ما ينبغي له أنْ يقوله، تصديقاً لامتثال ما يوحى إليه وعدم نطقه عن هواه، لهذا نجد أنّ عبارة (قل) قد تكرّرت في القرآن الكريم أكثر مِن ثلاثمِئة مرّة ليدرك مَنْ يقرأ القرآن أنّ محمّداً (صلّى الله عليه وآله وسلّم) مُخاطَب يُلقى إليه الخطاب إلقاءً، وليس متكلّماً ينطق به عن هواه وما يجول في نفسه.
كما نجد أنّ الفرق يتجلّى أكثر ويزداد وضوحاً بين ذات الله وصفاته، كونه المُتكلّم والمنزِّل للوحي وبين ذات نبيّه وصفاته كونه المخاطَب والمتلقّي للوحي، وذلك في آيات العتاب الإلهي لرسوله وإنذاره وتهديده، وتختلف درجات هذا العتاب والإنذار، فمنه ما يكون خفيفاً مشوباً بالعفو والغفران على تفويته الأَوْلى، كما في قوله تعالى لرسوله في شأن مَن أذِن لهم بالعفو عن القتال في غزوة تبوك: ( عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتّى يَتَبَيّنَ لَكَ الّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكاذِبينَ ) (١) .
وكذلك قوله تعالى: ( إِنّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً * لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا تَقَدّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخّرَ وَيُتِمّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً ) (٢) .
ومنه الشديد الذي يكون بلسان التوجيه لرسوله مقترناً بالإنذار والتهديد وبمستويات تختلف في الشدّة، فمن درجاته الأولية قوله تعالى: ( يَا أَيّهَا الرّسُولُ بَلّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ... ) (٣) ، ويشتدّ أكثر في قوله تعالى: ( وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذاً لاتّخَذُوكَ خَلِيلاً * وَلَوْلاَ أَن ثَبّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً * إِذاً لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً ) (٤) .
____________________
(١) يونس: ١٥ - ١٦.
(٢) الأعراف: ١٨٨.
(٣) الكهف: ١١٠.
(٤) الأنعام: ٥٠.
ويبلغ الإنذار أعلى درجاته لتتضاءل أمامه كلّ صوَر التهديد والوعيد الأُخرى، وذلك في قوله تعالى: ( وَلَوْ تَقَوّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ * لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا مِنكُم مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ) (١) .
وهكذا نجد أنّ آيات التأديب والعتاب وآيات الوعيد والإنذار تكشف لنا أنّ الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، كان يتمثّل صفة المخلوق الضعيف الخاضع لربّه الخالق القادر القاهر ذي القوّة المتين، الذي لا معقّب لحكمه وإرادته، وفي نفس الوقت تكشف لنا الآيات الكريمة عن كامل وعي الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وإدراكه للفرق بين ذاته المأمورة وذات الله الآمرة، والذي يجعله مستحضراً بوضوح الفرق بين الوحي القرآني الذي ينزل عليه، وبين الإلهام الإلهي في حديثه النبويّ الخاص.
وهذا هو الذي جعله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ينهى في أوّل عهد نزول الوحي القرآني عن تدوين شيء عنه سوى القرآن الكريم، حفظاً لصفته الربّانيّة الخالصة من أنْ تختلط بشيءٍ غيره، لهذا كان يدعو كتّاب الوحي فور نزول شيء من القرآن الكريم لتدوينه، حتّى لو كان آيةً أو بعضَ آية.
الصورة الثانية: وهي التي تُبدي لنا موقف النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) تجاه الوحي القرآني، وهو مستسلم لأمر الله فيه لا يملك أيّ اختيار وإرادة في نزوله عليه أو انقطاعه عنه، فهو يدرك تماماً أنّ التنزيل القرآني منسلخٌ عن الطبيعة البشريّة وإرادتها انسلاخاً تامّاً. فتارة يتتابع الوحي القرآني ويحمى حتّى يشعر أنّه يكثر عليه، وتارةً وبدون سابق إنذار يفتر عنه وهو في أشدّ الحاجة إليه.
وممّا يؤكّد ذلك أيضاً هو أنّ الوحي القرآني ينزل على رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في أحوال مختلفة، منها: ما يكون في منامه، فما يكاد يغفو إغفاءةً حتّى ينهض ويرفع رأسه مُبتسماً وقد أوحيَت إليه سورة الكوثر. ومنها ما يكون وهو وادع في بيته وقد بقي من الليل ثلثه، فتنزل عليه آية التوبة في الثلاثة الذين خافوا، وهي قوله تعالى:
____________________
(١) الحاقّة: ٤٤ - ٤٧.
( حَتّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنّوا أَن لاَمَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِلاّ إِلَيْهِ ثُمّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنّ اللّهَ هُوَ التّوّابُ الرّحِيمُ ) (١) .
وهكذا نجد أنّ الوحي القرآني ينزل على قلب النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في ليلٍ دامس أو ضُحى النهار، وفي البرد القارس أو حرّ الهجير، وفي استجمام الحضر أو وعثاء السَفَر، وفي هدأة السوق أو وطيس الحرب... وهو تعبيرٌ واضح عن تمام الانسلاخ وفقدان اختيار النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في نزول الوحي أو انقطاعه.
ونجد أنّ ذلك يتجسّد أكثر في انقطاع الوحي القرآني تماماً عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في الوقت الذي كان في أشدّ الشوق والطلب له، بعد أنْ نزل عليه الروح الأمين بأوائل سورة العلق: ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبّكَ الّذِي خَلَقَ ) ، ثمّ فتر ثلاث سنوات فحزن فيها النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، بعدها حمي الوحي وتوالى عليه فاستبشر النبيّ به وغمرته فرحة الوصال.
ويتجسّد ذلك أيضاً حين أبطأ الوحي بعد حديث الإفك الذي رمى به المنافقون زوج النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وشهّروا به إمعاناً في فضحها، حتّى عصف هذا الأمر بقلب الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وثَقُل عليه عدم نزول الوحي. وقد تصرّمت على الحادثة مدّة من الزمن كانت عليه أثقل من سنين متمادية بعد أنْ خاض المنافقون في زوجه خوضاً باطلاً.
فما بال النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لا يستنجد بالوحي النفسي المزعوم، أو يسرع الى استنزال الأمر الإلهي على طريقة الرهبان وأهل التعاويذ والأسجاع فيبرّئ زوجه من قذف المنافقين؟
كما ونجد أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قد حزَّ في نفسه غمز اليهود له، فظلّ يقلب وجهه في
____________________
(١) التوبة: ١١٨.
السماء ستّة عشر شهراً أو أكثر تحرّقاً وشوقاً إلى تحويل القبلة مِن المسجد الأقصى إلى الكعبة المشرّفة، يترقّب الوحي علّه ينزل عليه بهذا التحويل، فلِم لم يُعالج النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) هذا الأمر بالوحي النفسي المزعوم أو باستنزالٍ عاجل للوحي يزيل عنه همّه ويحقّق له ما يتمنّاه؟ إلاّ أنّه ظلّ خاضعاً مترقّباً قرابة العام ونصف العام حتّى نزل عليه الوحي بالآية القرآنيّة الكريمة: ( قَدْ نَرَى تَقَلّبَ وَجْهِكَ فِي السّماءِ فَلَنُوَلّيَنّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) .
ممّا سبق نعلم أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كان على يقينٍ تام، أنّه لا يملك حولاً ولا قوّةً أمام الوحي القرآني، فهو مستقلٌ عن ذاته وقلبه، فقد يستعصي عليه رغم شوقه وحاجته إليه، وقد يحمى ويتتابع حتّى ليكثر عليه، ففؤاده مطمئن، وضميره واعٍ، وقلبه منطوٍ على اعتقادٍ راسخ بأنّ منشأ هذا الوحي ومصدره هو الله علاّم الغيوب.
الصورة الثالثة: وفيها يُظهر النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) حرصه الشديد على القرآن الكريم وخشيته مِن نسيان بعض آيات التنزيل القرآني وضياعها، فيعمد إلى التعجيل في قراءة القرآن قبل أنْ يُقضى إليه وحيه، فيجتهد في ترديده ويبذل من نفسه وفكره الجهد الكبير لئلاّ يفوته شيءٌ منه. إلاّ أنّ الله تعالى ينهاه عن ذلك في قوله تعالى: ( وَلاَ تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَبّ زِدْنِي عِلْماً ) (٢) .
ويرشده الله إلى عدم حاجته إلى تمرين ذاكرته لحفظ آيات القرآن النازلة، ويؤكّد له أنّ عليه سُبحانه جمعه وقرآنه، وذلك في قوله تعالى: ( لاَ تُحَرّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَاْنَاهُ فَاتّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمّ إِنّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ) (٣) .
____________________
(١) البقرة: ١٤٤.
(٢) طه: ١١٤.
(٣) القيامة: ١٦ - ١٩.
ويضمن له عدم نسيانه في قوله تعالى: ( سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَى ) (١) .
كلّ ذلك يؤكّد لنا أنّ الإرادة والاختيار النبويّ ليس دخيلاً، بأيّ شكلٍ من الأشكال، في الوحي القرآني لا في مضمونه ولا في طريقة وزمان ومكان نزوله، وحتّى في حفظه وجمعه وقرآنه وبيانه. أو لا يشكّل ذلك نقضاً تامّاً لمقولة الوحي النفسي، ودليلاً حاسماً وبرهاناً ساطعاً على ثبوت الوحي الإلهي للنبيّ محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وأنّه كان يعي تمام الوعي الفرق الكامل بين ذاته الخاضعة لأمر الله في تنزيله القرآني، وبين ذات الله القاهرة بأمرها وتنزيلها، وهو لا يملك إزاء ذلك مِن أمر نفسه شيئاً؟(٢) .
وبضمّ هذه الصوَر الثلاث بلحاظاتها المختلفة إلى الجانبين الأوّلين لا نجد لنظريّة الوحي النفسي أيّ أساس تقوم عليه، بل ونحكم ببطلانها وبطلان ما هو في سياقها مِن شُبهات حول الوحي الإلهي للنبيّ محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وتثبت حقيقته ثبوتاً قطعيّاً لا مجال للتردّد فيه.
____________________
(١) الأعلى: ٦.
(٢) لمزيد مِن التفصيل في مسألة الوحي ومناقشة الشُبهات الواردة حولها راجع: رضا، محمّد رشيد - الوحي المحمّدي، والدكتور الصالح، صبحي - مباحث علوم القرآن، والحكيم، محمّد باقر - علوم القرآن. ومعرفة، محمّد هادي - التمهيد في علوم القرآن ج١.
الخَاتِمَةُ
في خاتمة الكتاب لابدّ لنا من بيان بعض المسائل، التي يفترض أخذها بنظر الاعتبار عند تقويم هذه الدراسة، أو عند السعي لتطويرها إلى المستوى الذي تستوعب فيه كلّ قضايا ومطالب موضوعاتها الجزئيّة، التي طويناها بسبب الاختصار الذي قصدناه فيها فنقول:
أولاً: إنّ الدراسات التي تناولت الاستشراق باعتباره حركة ذات أهداف خاصّة، ومحتوى له نتائج وثمار، سَواء في عالم الفكر بآفاقه المختلفة أم في عالم الواقع بأبعاده الاجتماعيّة والسياسيّة، لا تتمتّع بالشمول الذي يستوعب تلك الحركة وذلك المحتوى، ولم تنظر إليه باعتباره وحدة مترابطة تمكّن الناظر المقوّم له من إعطاء الحكم المحيط والدقيق عليه.
فنجد أنّ بعضها انحصر موضوعه بنشأة وجذور تكوّن الاستشراق، وجاء البعض الآخر محدوداً بالقريب والمعاصر منه، وتناول الآخر جانباً جزئيّاً من محتوى نتاجه وثمراته، وهكذا.
إنّ هذا التفكيك في دراسة الاستشراق والتناول التجزيئي له، سيفقدنا القدرة على الوصول إلى العمق المطلوب والإحاطة الشاملة بأهدافه ونتائجه الواقعيّة، واكتشاف المرامي الخفيّة له.
ونحن هنا لا نبخس قيمة الدراسات التي أُنجزت في هذا الموضوع الشائك والحسّاس، بل نؤكّد أنّها كانت ذات قيمة علميّة عالية في مواردها المحدودة والجزئيّة.
ثانياً: افتقدت أغلب الدراسات التي تناولت الاستشراق إلى التمحيص الكامل للأهداف والمرامي الخفيّة له ضمن مجمل الأهداف المُعلنة، وقصرت ذلك على جانب ارتباطه بالتبشير والحركة الصليبيّة. وهذا وإنْ كان صحيحاً في بعض مراحله، إلاّ أنّ تحوّلات أساسيّة طرأت عليه قرَنَت حركته ومحتواه وأهدافه بحركة ومحتوى وأهداف الاستعمار الحديث ذي البُعد العلماني بالشكل الذي تمخّض عنه ما يُمكن أنْ نسمّيه بنظريّات الاستشراق الاستعماري.
وهذا هو الذي يكشف لنا عن أهمّ أسرار نجاح الاستعمار الحديث في تحقيق أهدافه الخبيثة، في الهيمنة على الشرق الإسلامي خصوصاً في الجانب الثقافي والتربوي، والنجاح في تحقيق ما يسمّى بقابليّة الاستعمار أو الاستعمار المنجي.
ثالثاً: لقد قام مجموعة مِن المفكّرين والعلماء الإسلاميّين بتتبّع الإنتاج الموسوعي للمستشرقين وتقصّي موارد الدسّ والتشويه في موادّها، أو اصطناع الشبهات حول أُمّهات المسائل الإسلامية فيها، إلاّ أنّه جاء ناقصاً من جهتين:
الجهة الأُولى: عدم استيعابهم لكافّة موارد الدسّ والتشويه أو إثارة الشُبهات، الأمر الذي يقتضي تصدّي أهل العلم والفكر من الإسلاميّين، لإتمام ما بدأه الروّاد الأوائل في هذا المجال.
الجهة الثانية: جاء العديد مِن المعالجات العلميّة لموارد الدسّ والتشويه الاستشراقي، وكذلك الردود على شُبهاتهم المختلفة سطحيّاً ونقضيّاً في الغالب مفتقداً إلى الردّ الحَلّي التامّ والعمق المناسب. وهذا أيضاً جدير بأنْ يكون مورد اهتمامٍ خاصٍّ لسدّ النقص فيه وإشباعه موضوعيّاً وفق النهج العلمي المطلوب.
رابعاً: إنّ العديد من معالجات الدسّ والتشويه الاستشراقي في الإسلام، وردود الشبهات المثارة مِن قِبلهم حوله كانت وِفق نظرة مذهبيّة خاصّة، كما هو الأمر في معالجات وردود موادّ دائرة المعارف الإسلامية مثلاً، وبذلك افتقرت في
منهجها ومضامينها العلميّة إلى رؤية ونظريّة مدرسة أهل البيت (عليهم السلام)، خصوصاً إذا عرفنا أنّ بعض معالجات الدسّ والتشويه وردود الشبهات تلك لا يستقيم عقائديّاً وعلميّاً ومنطقيّاً، إلاّ على أساس رؤية ونظريّة مدرسة أهل البيت (عليهم السلام)، وهذا بحدّ ذاته يشكّل مبرّراً مبدئيّاً لإعادة النظر في تلك المعالجات والردود وبنائها من جديد.
وننهي خاتمتنا هذه بتجديد الدعوة لإعادة دراسة الاستشراق بنظرة شموليّة مترابطة، والتركيز على تقويم محتوى الإنتاج الموسوعي له، وتدعيم الرؤية العلميّة والمنطقيّة لمعالجات دسّ وتشويه المستشرقين في الإسلام، وردود الشبهات التي أثاروها حوله برُؤى ونظريّات مدرسة أهل بيت النبوّة والعصمة (عليهم السلام)، تلك المدرسة الإسلامية الرائدة التي أسّسها رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وتعاهدها أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) من بعده لتحفظ للإسلام أُصوله ومعالمه وتبيّن أحكامه وفروعه، بعيداً عن أهواء الجهل وأغراض السلاطين، ليبقى الإسلام كما جاء به الرسول الأمين محمّد بن عبد الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، أصيلاً لا ينحرف وكاملاً لا ينثلم.
وأهل البيت (عليهم السلام) أدرى بما فيه، وهم الذي قرنهم رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بكتاب الله العزيز وقال فيهم:
(إنّي تاركٌ فيكم أمرَين إنْ أخذتم بهما لنْ تضلّوا: كتاب الله عزّ وجلّ وأهل بيتي عترتي، أيّها الناس اسمعوا وقد بُلّغت، إنّكم ستردون عليّ الحوض فأسألكم عمّا فعلتم في الثقلين، والثقلان: كتاب الله جلّ ذكره وأهل بيتي، فلا تسبقوهم فتهلكوا، ولا تعلّموهم فانهم أعلم منكم)(١) .
وقال (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فيهم أيضا:(ألا إنّ أهل بيتي أمانٌ لكم فأحبّوهم بِحُبّي وتمسّكوا
____________________
(١) الأُصول من الكافي (كتاب الحجّة) ١: ٢٩٤، وينابيع المودّة: ٣٤ باختلاف في بعض الألفاظ وإضافة (ولا تخلفوا عنهم).
بهم لنْ تضلّوا) (١) . وقال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) فيهم:(انظروا أهل بيت نبيّكم فالزموا سمتهم واتّبعوا أثرهم، فلن يُخرجوكم مِن هدىً ولنْ يعيدوكم في ردى) (٢) .
وقال فيهم الإمام الباقر (عليه السلام):(شرّقا وغرّبا لنْ تجدا علماً صحيحاً إلاّ شيئاً يخرج مِن عندنا أهل البيت) (٣) . وقال الإمام الصادق (عليه السلام):(انظروا علمكم هذا عمّن تأخذونه فإنّ فينا أهل البيت في كلّ خلَفٍ عدولاً ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المُبطلين وتأويل الجاهلين) (٣) . وقال (عليه السلام) فيهم أيضاً:(يا يونُس، إذا أردت العِلم الصحيح فخُذ عن أهل البيت، فإنّا رويناه وأوتينا شرح الحكمة وفصل الخطاب) (٥) .
وهذه الروايات هي غيضٌ من فيض ما ورد عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأئمّة أهل بيته (عليهم السلام)، وكلها تحكي المصداق الحقّ لقوله تعالى: ( فَسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْرِ إِن كُنتُم لاَ تَعْلَمُونَ ) (٦) صدق الله العليّ العظيم والحمد لله ربّ العالمين.
____________________
(١) بحار الأنوار ٣٦: ٣٤٢.
(٢) نهج البلاغة: خ٩٧.
(٣) بحار الأنوار ٢: ٩٢.
(٤) بحار الأنوار ٢: ٩٢.
(٥) بحار الأنوار ٢٦: ١٥٨.
(٦) النحل: ٤٣.
الفهرست الإجمالي
* فهرس الآيات الشّريفة
* فهرس الأحاديث الشّريفة
* فهرس مصادر الكتاب
* فهرس المحتويات
فهرس الآيات الشريفة
الآية الرقم الصفحة
سورة البقرة
( أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ ) ٧٥ ١٤ و٢٤٠
( وَلَمّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللّهِ مُصَدّقٌ لِمَا مَعَهُمْ... ) ٨٩ ١٥ و١٨
( الّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ) ١٤٦ ١٥
( أَوَ كُلّمَا عَاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ... ) ١٠٠ ١٥
( وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللّهُ... ) ٨٨ ١٦
( أَتَأْمُرُونَ الْنّاسَ بِالْبِرّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ... ) ٤٤ ١٦
( وَلَمّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللّهِ مُصَدّقٌ لِمَا مَعَهُمْ... ) ١٠١ ١٧
( وَدّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدّونَكُمْ ) ١٠٩ ١٧
( مَا يَوَدّ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ... ) ١٠٥ ١٨
( وَقَالُوا كُونُوا هُودَاً أَوْ نَصَارَى... ) ١٣٥ ١٨ و٢٧
( وَقَالُوا لَنْ تَمَسّنَا النّارُ... ) ٨٠ ٢٢
( يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ... ) ٤٠ ٢٤
( أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ... ) ٧٥ - ٧٧ ٢٥ و٣٢٥
( وَلَئِنْ أَتَيْتَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ... ) ١٤٥ ٢٥
( إِنّ الّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللّهُ... ) ١٧٤ ٢٥
( فَوَيْلٌ لِلّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ.. ) ٧٩ ٢٥
( وَلَنْ تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النّصَارَى... ) ١٢٠ ٢٧
( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ... ) ٢١٩ ٢٤٥
( مَا نَنَسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا... ) ١٠٦ ٢٥١
( أُوْلئِكَ الّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدّنْيَا... ) ٨٦ ٢٦٥
( شَهْرُ رَمَضَانَ الّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ) ١٨٥ ٢٨٩ و٢٩٠
( وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ) ١٢٧ ٢٩٠
( وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنّاسِ وَأَمْناً... ) ١٢٥ ٢٩٠
( قَدْ نَرَى تَقَلّبَ وَجْهِكَ فِي السّماءِ... ) ١٤٤ ٢٩٨ و٣٤٣
( مَا وَلّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ) ١٤٢ ٢٩٨
( حافِظُوا عَلَى الصّلَوَاتِ وَالصّلاَةِ الْوُسْطَى ) ٢٣٨ ٣٠١
آل عمران
( يَا أَهْلَ الكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقّ بِالْبَاطِلِ.. ) ٧١ ١٤
( وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ... ) ١٨٧ ١٤ و١٦ و٢٤٠
( وَدّت طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ... ) ٦٩ ١٦
( وَقَالَت طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا... ) ٧٢.
( وإِنّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ... ) ٧٨ ١٧
( وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ ) ٧٥ ١٩
( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ ) ٦٤ ٢١
( أَلَمْ تَرَ إَلَى الّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ... ) ٢٣ ٢١
( هَا أَنْتُمْ هؤُلاَءِ حَاجَجْتُمْ فِيَما لَكُم بِهِ عِلْمٌ ) ٦٦ ٢١
( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ... ) ٧٠ ٢٢
( الّذِينَ قَالُوا إِنّ اللّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا ) ١٨٣ ٢٣
( وَإِنّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ... ) ١٩٩ ٢٣
( يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا... ) ١٠٠ ٢٥
( إِنّ الدّينَ عِندَ اللّهِ الْإِسْلاَمُ... ) ١٩ ٢٥
( لَقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الّذِينَ قَالُوا... ) ١٨١ ٢٦
( مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلاَ نَصْرَانِيّاً ) ٦٧ ١٨٢ و٢٤١
( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ... ) ٦٥ - ٦٦ ٢٤١
( إِنّ أَوّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلّذِي بِبَكّةَ.. ) ٩٦ -٩٧ ٢٩١
النساء
( مِنَ الّذِينَ هَادُوا يُحَرّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَواضِعِهِ... ) ٤٦ ١٤ و١٩ و٢٤٠
( أَلَمْ تَرَ إَلَى الّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ... ) ٥١ ١٨
( فَبِظُلْمٍ مِنَ الّذِينَ هَادُوا حَرّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيّبَاتٍ... ) ١٦٠ ٢٠
( لكِنِ الرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ... ) ١٦٢ ٢٣
( وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النّسَاءِ... ) ٢٢ ١٧٤
( يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى... ) ٤٣ ٢٤٥
( أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ... ) ٤٤ -٤٦ ٣٣٤
المائدة
( يَا أَيّهَا الرّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ... ) ٤١ ١٦
( وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللّهِ وَأَحِبّاؤُهُ... ) ١٨ ١٩
( وَتَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ... ) ٦٢ ٢٠
( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنّا ) ٥٩ ٢٠
( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيّنُ لَكُمْ... ) ١٥ ٢٠
( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيّنُ لَكُمْ... ) ١٩ ٢١
( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ... ) ٦٨ ٢١
( وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ... ) ٦٤ ٢٢
( وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنّا وَقَد دَخَلُوا بِالْكُفْرِ... ) ٦١ ٢٢
( يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنّصَارَى أَوْلِيَاءَ ) ٥١ ٢٣
( يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتّخِذُوا الّذِينَ اتّخَذُوا... ) ٥٧ ٢٤
( وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالنّبِيّ... ) ٨١ ٢٤
( لاَ يَتَنَاهُوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ ) ٧٩ ١٥٩
( لَتَجِدَنّ أَشَدّ النّاسِ عَدَاوَةً لِلّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ.. ) ٨٢ ٢٣٩
( يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْخَمْرُ... ) ٩٠ ٢٤٥
( فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ لَعَنّاهُمْ... ) ١٣ -١٤ ٣٣٤
( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيّنُ... ) ١٥ -١٦ ٣٣٥
( يَا أَيّهَا الرّسُولُ بَلّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ... ) ٩١ ٢٢
( سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا يَصِفُونَ ) ١٠٠ ٢٥٧
( قُل لا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ... ) ٥٠ ٣٣٩
الأعراف
( وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ... ) ٧٣ ٢٤٩
( وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا ) ١٧٥ ٢٩٢
( قُل لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً ) ١٨٨ ٣٣٩
الأنفال
( الّذِينَ عَاهَدتّ مِنْهُمْ ثُمّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلّ مَرّةٍ... ) ٥٦ ١٥
( وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاّ مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ) ٣٥ ٢٩١
التوبة
( يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنّ كَثِيراً مِنَ الأَحْبَارِ وَالرّهْبَانِ... ) ٣٤ ٢٠
( إِلَى الّذِينَ عَاهَدْتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ... ) ٤ ٢٤
( إِلاّ الّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ... ) ٧ ٢٤
( قَاتِلُوا الّذِينَ لاَيُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ... ) ٢٩ ٢٦
( هُوَ الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ... ) ٣٣ ٢٤١
( عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ... ) ٤٣ ٣٤٠
( حَتّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ... ) ١١٨ ٣٤٢
يونس
( فَالْيَوْمَ نُنَجّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً... ) ٩٢ ٣٣٦
( وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيّنَاتٍ.. ) ١٥ - ١٦ ٣٣٨
هود
( فَبَشّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ) ٧١ ٢٤٣ و٢٤٧
( وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ... ) ٦١ ٢٤٩
( وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ... ) ٥٠ ٢٤٩
( تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ... ) ٤٩ ٢٩٣
( وَأَقِمِ الصّلاَةَ طَرَفَيِ النّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللّيْلِ... ) ١١٤ ٣٠٠ و٣٠١
يوسف
( وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ... ) ٢١ ٨
( ...وَيُتِمّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ... ) ٦ ٢٤٨
الرعد
( يَمْحُوا اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ... ) ٣٩ ٢٥١
إبراهيم
( الْحَمْدُ للّهِ الّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ... ) ٣٩ ٢٤٨
النحل
( وَمِن ثَمَرَاتِ النّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً... ) ٦٧ ٢٤٥
( وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً... ) ٧٢ ٢٤٧
( وَإِذَا بَدّلْنَا آيَةً مّكَانَ آيَةٍ... ) ١٠١ ٢٥١
( وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنّهُمْ يَقُولُونَ إِنّمَا يُعَلّمُهُ... ) ١٠٣ ٢٩٣ و٣٢٦ و٣٣٢
( فَسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْرِ إِن كُنتُم لاَ تَعْلَمُونَ ) ٤٣ ٣٥٠
الإسراء
( أَقِمِ الصّلاَةَ لِدُلُوكِ الشّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللّيْلِ... ) ٧٨ ٣٠٠
( وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ... ) ٧٣ -٧٥ ٣٤٠
الكهف
( قُلْ إِنّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَي... ) ١١٠ ٣٣٩
طه
( وَلاَ تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ... ) ١١٤ ٣٤٣
الأنبياء
( بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ بَلِ افْتَرَاهُ... ) ٥ ٣٢٦
الحج
( وَإِذْ بَوّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ... ) ٢٦ - ٢٧ ٢٩٠
النور
( رِجَالٌ لاّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللّهِ... ) ٣٧ ٢٧٣
( اللّهُ نُورُ السّماوَاتِ وَالأَرْضِ ) ٣٥ ٣٠٩
الفرقان
( وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذَا إِلاّ إِفْكٌ... ) ٤ -٥ ٣٢٦
الشعراء
( كَذّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ... ) ١٤١ - ١٤٤ ٢٤٩
القصص
( الّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ) ٥٢ ٢٣
( لِتُنذِرَ قَوْماً مّا أَتَاهُم مِن نّذِيرٍ مِن قَبْلِكَ... ) ٤٦ ٢٤٨
( وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرّتُ عَيْنٍ لّي وَلَكَ... ) ٩ ٣٣٦
السجدة
( لِتُنذِرَ قَوْماً مّا أَتَاهُم مِن نّذِيرٍ... ) ٣ ٢٤٨
الأحزاب
( وَأَنزَلَ الّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ... ) ٢٦ ٢٦
سبأ
( وَمَا آتَيْنَاهُم مِن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا... ) ٤٤ ٢٤٨
فاطر
( إِنّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقّ بَشِيراً وَنَذِيراً... ) ٢٤ ٢٤٩
يس
( لِتُنذِرَ قَوْماً مّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ... ) ٦ ٢٤٨
الصافّات
( سُبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعِزّةِ عَمّا يَصِفُونَ... ) ١٨٠ - ١٨٢ ٢٥٧
( أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ) ١٢٥ ٣٠٦ و٣١١
الشورى
( شَرَعَ لَكُم مِنَ الدّينِ مَا وَصّى بِهِ نُوحاً... ) ١٣ -١٥ ٢٤٠
( وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلّمَهُ اللّهُ إِلاّ وَحْياً... ) ٥١ -٥٢ ٣٣٧ و٣٣٨
الدخان
( أَنّى لَهُمُ الذّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ... ) ١٣ -١٤ ٣٢٦
الفتح
( إِنّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً... ) ١ -٢ ٣٤٠
الذاريات
( فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً... ) ٢٨ ٢٤٨
القمر
( كَذّبَتْ ثَمُودُ بِالنّذُرِ ) ٢٣ ٢٥٠
الحشر
( هُوَ الّذِي أَخْرَجَ الّذِينَ كَفَرُوا... ) ٢ ٢٦
( هُوَ اللّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوّرُ... ) ٢٤ ٣١٠
الجمعة
( قُل يَا أَيّهَا الّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنّكُمْ أَوْلِيَاءُ للّهِ... ) ٦ ٢٣
الحاقّة
( كَذّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ... ) ٤ ٢٥٠
( وَلَوْ تَقَوّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ... ) ٤٤ - ٤٧ ٣٤٠
القيامة
( لاَ تُحَرّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ... ) ١٦ - ١٩ ٣٤٣
المطفّفين
( وَيْلٌ لِلْمُطَفّفِينَ... ) ١ -٣ ٢٧٣
الأعلى
( بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدّنْيَا... ) ١٦ - ١٩ ٢٦٥
( سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَى ) ٦ ٣٤٤
الغاشية
( أَفَلاَ يَنظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ) ١٧ ١٤٧
العلق
( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبّكَ الّذِي خَلَقَ ) ١ ٣٤٢
فهرس الأحاديث الشريفة
الحديث - الصفحة
(أحياناً يأتيني مثل صَلصَلة الجرَس وهو أشدّه علي...) ٣٣٨
(إنّ النبيّ لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوماً...) ٢٨٤
(انظروا أهل بيت نبيّكم فألزِموا سمتهم واتّبعوا أثرهم...) ٣٥٠
(انظروا علمكم هذا عمّن تأخذونه فانّ فينا أهل البيت...) ٣٥٠
(إنّي تاركٌ فيكم أمرَين إنْ أخذتم بهما لنْ تضلّوا...) ٣٤٩
(ألا إنّ أهل بيتي أمانٌ لكم، فأحبّوهم بحبّي وتمسّكوا بهم لن تضلّوا...) ٣٥٠
(تحوّلت القبلة الى الكعبة بعدما صلّى النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بمكّة ثلاث عشرة سنة...) ٢٩٨
(دخل النبيّ المدينة وإذا أُناسٌ من اليهود يعظّمون عاشوراء...) ٢٨٥
(سألت أبا جعفر (عليه السلام) عمّا فرض الله عزّ وجل من الصلاة...) ٣٠٠
(سألته عن خطبة رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أَقَبْلَ الصلاة أو بعدها...) ٢٨٠
(شرّقا وغرّبا لنْ تجِدا علماً صحيحاً إلاّ شيئاً يخرج مِن عندنا أهل البيت...) ٣٥٠
(قدِم النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء...) ٢٨٤
(قدِم النبيّ المدينة واليهود تصوم عاشوراء...) ٢٨٤
(كانوا يصومون عاشوراء قبل أنْ يُفرض رمضان، وكان يوماً تسترّ فيه الكعبة...) ٢٨٣
(كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهليّة، وكان النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يَصومه...) ٢٨٣
(كان يوم عاشوراء تعدّه اليهود عيداً...) ٢٨٥
(لعن قوماً زعموا أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أخذ الأذان من عبد الله بن زيد...) ٢٩٧
(لمّا أُسري برسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) الى السماء فبلغ البيت المعمور، وحضرت الصلاة...) ٢٧٩
(لمّا قدم النبيّ المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء...) ٢٨٤
(لمّا قدم رسول الله المدينة واليهود تصوم عاشوراء...) ٢٨٤
(لمّا هبط جبرئيل (عليه السلام) بالأذان على رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كان رِأسه في حجر...) ٢٧٩ و٢٩٧
(والله لتقتلنّ هذه الأُمّة ابن نبيّها في المحرّم...) ٢٨٨
(وقال تعالى: (حافِظُوا عَلَى الصّلَوَاتِ وَالصّلاَةِ الْوُسْطَى) وهي صلاة الظهر...) ٣٠١
(يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فخُذ عن أهل البيت...) ٣٥٠
(ينزل الوحي على نبيّكم فتزعمون أنّه أخذ الأذان من عبد الله بن زيد...) ٢٧٩
فهرس مصادر الكتاب
أولاً: المصادر العربيّة والمعرّبة
أ - الكتب:
١ - القرآن الكريم.
٢ - الميزان في تفسير القرآن - السيّد محمّد حسين الطباطبائي.
٣ - البيان في تفسير القرآن - السيّد أبو القاسم الخوئي.
٤ - علوم القرآن - السيّد محمّد باقر الحكيم.
٥ - التمهيد في علوم القرآن - الشيخ محمّد هادي معرفة.
٦ - الهدى إلى دين المصطفى - الشيخ محمّد جواد البلاغي.
٧ - صلح الإمام الحسن (عليه السلام) - الشيخ راضي آل ياسين.
٨ - سيرة الأئمّة الاثني عشر - هاشم معروف الحسني.
٩ - وسائل الشيعة - الحِر العاملي.
١٠ - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الشيخ محمّد حسن النجفي.
١١ - الغدير في الكتاب والسنة والأدب - الشيخ عبد الحسين أحمد الأميني النجفي.
١٢ - معالم المدرستين - السيّد مرتضى العسكري.
١٣ - أمالي الشيخ الصدوق.
١٤ - تاريخ الطبري.
١٥ - صحيح البخاري.
١٦ - الوحي المحمّدي - محمّد رشيد رضا.
١٧ - شاهد القرن الطالب - مالك بن نبيّ.
١٨ - الإسلام على مفترق الطُرق - محمّد أسد.
١٩ - الإسلام وحركة التاريخ - أنور الجندي.
٢٠ - الصراع بين الفكرة الإسلاميّة والفكرة الغربيّة - أبو الحسن الندوي.
٢١ - انتشار الإسلام والدعوة إليه - سامي محمّود.
٢٢ - الظاهرة القرآنيّة - مالك بن نبيّ.
٢٣ - الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي - الدكتور محمّد البهي.
٢٤ - تاريخ الإسلام - الدكتور حسن إبراهيم.
٢٥ - التبشير والاستشراق - محمّد عزّت إسماعيل الطهطاوي.
٢٦ - التبشير والاستعمار في البلاد العربيّة - الدكتور مصطفى خالدي والدكتور عمر فروخ.
٢٧ - السياسة الفرنسيّة في الشرق الأوسط - المركز الإسلامي للأبحاث السياسيّة.
٢٨ - تاريخ العرب في الإسلام - جواد عليّ.
٢٩ - المستشرقون والإسلام - الدكتور حسين الهواري.
٣٠ - التبشير في منطقة الخليج العربي - الدكتور عبد الملك خلف التميمي.
٣١ - أرقام وآراء حول نظام البعث في العراق - فؤاد كاظم.
٣٢ - الوقائع الحقيقيّة - عليّ البازركان.
٣٣ - مصادر الدراسات الأدبيّة - يوسف أسعد داغر.
٣٤ - الاستشراق والخلفيّة الفكريّة للصراع الحضاري - محمود حمدي زقزوق.
٣٥ - حضارة الإسلام - صلاح الدين خدابخش.
٣٦ - تاريخ الأدب الأندلسي - الدكتور عبّاس إحسان.
٣٧ - الحلل السُندسيّة في الأخبار والآثار الأندلسيّة - شكيب أرسلان.
٣٨ - أثر العرب في الحضارة الأوربيّة - جلال مظهر.
٣٩ - في تراثنا العربي والإسلامي - توفيق الطويل.
٤٠ - السياسة الدولية في الشرق العربي - إسماعيل عادل.
٤١ - أضواء على الصهيونيّة - مصطفى السعدين.
٤٢ - بلاد الشام - وجيه الكوثراني.
٤٣ - الأُمّة العربيّة وقضيّة التوحيد - الدكتور محمّد عمارة.
٤٤ - الاتجاهات الوطنيّة في الأدب المعاصر - محمّد محمّد حسين.
٤٥ - حياة محمّد - أميل درمنغهام.
٤٦ - أُدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث - بطرس البستاني.
٤٧ - المستشرقون - نجيب العقيقي.
٤٨ - الدراسات العربيّة والإسلاميّة في الجامعات الألمانيّة - رودي بارت.
٤٩ - الاستشراق - ادوارد سعيد.
٥٠ - الدعوة إلى الإسلام - توماس أرنولد.
٥١ - صورة الإسلام في أوربّا في العصور الوسطى - ريتشارد سوذرن.
٥٢ - حضارة العرب في الأندلس - ليفي بروفنسال.
٥٣ - تراث الإسلام - تأليف مجموعة من المستشرقين تحت إشراف وتصنيف جوزيف شاخت وأدموند بوزورث.
٥٤ - جاذبيّة الإسلام - مكسيم رودنسون.
٥٥ - تطوّر العمارة الإسلاميّة في اسبانيا والبرتغال وشمال إفريقيا - إيلي لومبير.
٥٦ - تاريخ الفكر الأندلسي - أ. ج. بالنتيا.
٥٧ - المستشرقون الألمان - يوهاك فوك.
٥٨ - فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر - أحمد سمايلوفيتش.
٥٩ - دراسات في تاريخ الأدب العربي - إغناطيوس كراتشقوفسكي.
٦٠ - فضل الإسلام على الحضارة الأوربيّة - مونتغمري وات.
٦١ - تاريخ التمدّن الإسلامي - جرجي زيدان.
٦٢ - محمّد رسول الله - إيتين دينيه.
٦٣ - تاريخ فرنسا - جو ليمين.
٦٤ - البعثات اليسوعيّة - الدكتور طلال عتريسي.
٦٥ - مجمع جبل لبنان - شقالييه دومينيك.
٦٦ - فرنسا صديقة ومحامية - الخورس بطرس غالي.
٦٧ - باسم فلسطين - دانيال لوغاك.
٦٨ - تاريخ لبنان الحديث - كمال الصليبي.
٦٩ - وجهة الإسلام - هاملتون الكسندر جبّ.
٧٠ - محمّد في مكّة - مونتغمري وات.
٧١ - الشرق كما يراه الغرب - إيتين القيم.
٧٢ - تاريخ الشعوب الإسلاميّة - كارل بروكلمان.
٧٣ - تاريخ اليهود في بلاد العرب - إسرائيل ولفنسون.
٧٤ - الدولة العربيّة وسقوطها - يوليوس فلهاوزن.
٧٥ - تاريخ العالم للمؤرّخين - ثيودور نولدكه.
٧٦ - المذهب المحمّدي - هاملتون الكسندر جبّ.
٧٧ - الدعوة إلى الإسلام - سير توماس أرنولد.
٧٨ - في سبيل البعث - ميشيل عفلق.
٧٩ - سِفر الخروج.
٨٠ - سِفر اللاويين.
٨١ - سِفر العدد.
٨٢ - سِفر أخبار الأيّام الأوّل.
٨٣ - سِفر التثنية.
٨٤ - إنجيل متّى
٨٥ - إنجيل مرقس.
ب - الموسوعات :
١ - موسوعة المورد - منير البعلبكّي.
٢ - دائرة المعارف الإسلاميّة - مجموعة من المستشرقين.
ج - القواميس والمعاجم :
١ - القاموس المنجد في اللغة والأعلام.
٢ - الأعلام (قاموس تراجم) - خير الدين الزركلي.
٣ - لسان العرب (قاموس لغوي) - العلاّمة ابن منظور.
٤ - كتاب العين - الخليل بن أحمد الفراهيدي.
٥ - الدليل إلى المستعملات في اللغة العربيّة.
٦ - مجمع البحرين - الشيخ فخر الدين الطريحي.
٧ - النهاية في غريب الحديث والأثر - ابن الأثير (مجد الدين).
٨ - الجمهرة في لغة العرب - ابن دُرَيد (محمّد بن الحسن الأزدي).
د - الصحف والمجلاّت :
١ - مجلّة رسالة الجهاد - ليبيا.
٢ - مجلّة منار الإسلام - دولة الإمارات العربيّة المتّحدة.
٣ - مجلّة التوحيد - الجمهوريّة الإسلامية الإيرانيّة.
٤ - مجلّة العالم - لندن.
٥ - مجلّة العرفان - بيروت.
٦ - مجلّة نور الإسلام - بيروت.
٧ - مجلّة رسالة الإسلام - مصر.
٨ - مجلّة المنتقى - باريس.
٩ - مجلّة الدستور - بيروت.
١٠ - مجلّة البعث الإسلامي - الهند.
١١ - مجلّة دعوة الحق - المغرب.
١٢ - مجلّة رسالة الثقلين - المجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام) - الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة.
١٣ - صحيفة الأهرام: الملحق الأدبي (أهرام الجمعة) - القاهرة.
ثانياً: المصادر الأجنبيّة :
١ – CF. pown ٣٧, Islam And Missions.
٢ – The political Geography Of The Mohammadan Word.
٣ – CF – J – J. Wardenburg, L,Islam Dans Le Miroir De I,Occident (Paris – The Hague, ١٩٦٣).
٤ – Migne; Patrologio Latina, CL xxxlx.
٥ – CF. Southen.
٦ – Domj – Laclercq, Pierre Le Venerable (A Baye st. Wandrille, ١٩٤٦).
٧ – Bullet In Doeuvres Des Ecoles Dorient ١٨٦٢.
٨ – Christion Mission.
٩ – Julius Richter.
١٠ – Pottier.
١١ – Agnes Murphy, The Ideology of French Imperialism ١٨١٧ – ١٨٨١ (Washington: Catholic University of America Press, ١٩٤٨).
١٢ – Revue D, historie Des Missions.
١٣ – Paul Huvelin – Conger,s Francais Surga Syrie – Fascicule ١١١. Champe De Commeree Marseille ١٩١٩.
١٤ – Baudicour. Louis De: Le France en Syrie – Paris ١٨٦٠.
١٥ – Rochementeix C. P. J. Leban Et ١ ex Pedition Frandcaise En Syrie ١٨٦٠ – ١٨٦١ Documents Inedits Du General A. Ducroit Paris ١٩٢١.
١٦ – Milligan.
١٧ – Les Jesuites En Syrie.
١٨ – Ibid.
١٩ – R. Ristelhueber Traditions Francaises Au Liban Paris ١٩١٨.
٢٠ – Fuck, op. Cit, H. Deherain, Silver De Sacy.
٢١ – HARRISON – Ann – Atol in his hand, N.Y.١٩٥٨.
٢٢ – Zwemer. S.M. and Cantine, J. Op. Cit.
٢٣ – Burgoyne (Gertude Boll) London ١٩٦١.
الفهرس
كَلِمَةُ المَجَلَّةِ ٥
مُقدَّمَةٌ ٩
للعلاّمة الشيخ محمّد عليّ التّسخيرى ٩
الأمين العامّ للمجمع العالميّ لأهل البيت (عليه السلام) ٩
أهلُ الكتابِ وَالثَّقلينِ ١١
القسم الأوّل ١٤
١ - كتمان الحقّ وتحريفه: ١٤
٢ - نقض العهود والمواثيق: ١٥
٣ - النفاق والتضليل: ١٦
٤ - الحسد والتعصّب: ١٧
٥ - التعالي والاستهزاء: ١٨
٦ - الحقد والعدوان: ١٩
القسم الثاني ٢٠
١ - دعوة أهل الكتاب وترغيبهم فيه: ٢٠
٢ - التحاجّ إلى الحقّ: ٢١
٣ - الردّ على شُبهاتهم: ٢٢
٤ - كشف نواياهم وامتحان مدى صدقهم: ٢٢
٥ - إنصاف طلاّب الحق منهم: ٢٣
٦ - رفض ولايتهم: ٢٣
٧ - احترام العهود والمواثيق معهم: ٢٤
٨ - الحذر من إغوائهم وتضليلهم: ٢٤
٩ - التهديد والوعيد للمعاندين منهم: ٢٥
١٠ - لعن وقتال المحاربين منهم: ٢٦
العداء دائم ما دامت علّته ٢٧
الفصل الأوّل ٢٩
نشأة الاستشراق ٢٩
هوية الاستشراق ٣١
تعريف الاستشراق: ٣١
النشأة والبدايات ٣٨
نشأة الاستشراق والاقتران بالتبشير ٤٠
نشأة الاستشراق بين النهج العلمي والاستعداء التبشيري ٤٤
مبدأ الاستشراق اختراق ثقافي لدحر المسلمين في أوربّا ٤٨
أوّلاً: المسار الديني: ٤٨
ثانياً: المسار الفكري والسياسي: ٥٠
الاستعراب(١) أولاً ثمّ الاستشراق ٥٧
بروز نظريّات الاستشراق الاستعماري ٦٦
الفصل الثّاني ٦٩
المراحل والأدوار التي مرّت بها الحركة الاستشراقيَّةُ ٦٩
المرحلة الأُولى ٧١
مرحلة الانفتاح لاحتواء الحضارة الإسلاميّة ٧١
المرحلة الثانية ٧٤
مرحلة الفرز لاستلاب الحضارة الإسلاميّة ٧٤
المرحلة الثالثة ٧٥
مرحلة تغريب إفرازات الحضارة الإسلاميّة المُستلبة ٧٥
المرحلة الرابعة ٧٧
مرحلة استعمار الشرق وتطبيعه على الحضارة المغرّبة ٧٧
الفصل الثّالث ٧٩
المدارسُ الاستشراقيّة ٧٩
خلفيّات المستشرقين ٨١
الخلفيّة الأُولى: ٨١
الخلفيّة الثانية: ٨٢
الخلفية الثالثة: ٨٤
المدارس الاستشراقيّة ٨٦
النموذج: المدرسة الاستشراقيّة الفرنسيّة ٨٨
المميّزات الأساسيّة للمدرسة الاستشراقيّة الفرنسيّة ٨٩
نشأة المدرسة الاستشراقيّة الفرنسيّة وعوامل نموّها وتطوّرها ٩٧
مناطق نفوذ المدرسة الاستشراقيّة الفرنسيّة ١٠١
صيغ وأساليب المدرسة الاستشراقيّة الفرنسيّة وتشكيلاتها ١٠٤
الاختصاصات التبشيريّة إلى بلدان الشرق الإسلامي ١٠٧
أثر المدرسة الاستشراقيّة الفرنسيّة على الفكر الاستشراقي العام ١٢٩
الفصل الرابع ١٣٣
نماذج من أبرز الموضوعات التي ركّز عليها المستشرقون دسّهم وتشويههم ١٣٣
القرآن الكريم ١٣٧
إعجاز القرآن الكريم ١٣٧
الوحي القرآني ١٤١
ترجمة القرآن للغات الأُخرى ١٤٦
سيرة الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم)وأهل بيته (عليهم السلام) ١٤٩
الفصل الخامس ١٧٧
نماذج من كبار المستشرقين في منهج ١٧٧
تناولهم للشّرق الإسلامي ١٧٧
أرندجان فنسنك Arendjan Wensink ١٨١
صموئيل زويمر Samual Zwemer (١٨٦٧ - ١٩٥٢م) ١٨٥
لويس ماسينيون Louis Massignon ( ١٨٨٣ - ١٩٦٣م) ١٩٢
الفصل السّادس ١٩٩
نماذج من الدّسّ والتّشويه في الإنتاج الموسوعى للمستشرقين ١٩٩
دوائر المعارف (البريطانيّة، الأميركيّة، لاروس الفرنسية) ٢٠٢
الموسوعة العربيّة الميسّرة ٢٠٦
قاموس المنجد ٢١٠
الموسوعة الإسلاميّة الميسرة ٢١٤
دائرة المعارف الإسلاميّة ٢١٩
هويّة وخلفيّة أبرز كتّابها ٢٢٠
الدسّ والتشويه في موادّها (شُبهات وردود) ٢٣٦
ذكاء محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وخياله عماد دعوته ٢٣٧
تناقض القرآن والتردّد في بعض آياته ٢٤١
النسخ في القرآن الكريم: ٢٥٠
تأثّر محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) باليهوديّة والنصرانيّة والجاهليّة واستقاؤه منها في صياغة قرآنه ودينه الجديد ٢٦٠
المجموعة الأولى: ٢٨٢
المجموعة الثانية: ٢٨٣
مناقشة ما ورد في روايات المجموعتين: ٢٨٥
شعائر الإسلام وليدة إبداعات وتأثيرات متنوّعة ٢٩٣
غموض العديد من مقولات النبيّ محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) القرآنيّة ٣٠٤
ادّعاء النبيّ محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وابتكاره واصطناعه وتأثره بمَن حوله ٣١١
شُبهة المستشرقين حول الوحي: ٣٢٧
الخَاتِمَةُ ٣٤٣
الفهرست الإجمالي ٣٤٨
فهرس الآيات الشريفة ٣٥٠
فهرس الأحاديث الشريفة ٣٦٤
فهرس مصادر الكتاب ٣٦٦