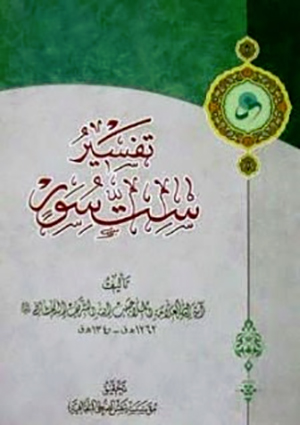بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
ترجمة المفسّر :
كان أبوه ملّا على مدد بن رمضان الساوجى (المتوفّى سنة ١٢٧٠ ق)، والّذى كان تلميذا لملا احمد النراقي (صاحب معراج السعادة، المتوفّى سنة ١٢٤٥ ق). انّه كان من علماء كاشان وفضلائها والّف عدّة كتب في الفقه والأصول.
كان مولد مفسّرنا هذا سنة ١٢٦١ او ١٢٦٢ ق كما تدلّ عليه الدلائل الموجودة في ترجمة ملا حبيب الله.
انّه قام بدراساته في كاشان ففى طهران ثمّ في كربلاء، وقضى برهة من حياته بعد العودة من العتبات في گلپايگان وصرف حياته الى آخرها في تدريس بكاشان لما أكبّ الى تأليف الكتب وارشاد الناس (١٢٨٢ ـ ١٣٤٠ ق).
انّه تتلمذ في حلقة كبار مثل : الحاج سيّد حسين ابن مير محمّد على الكاشاني (المتوفّى سنة ١٢٦٩ ق) والحاج مير محمد على بن سيد محمد الكاشاني (المتوفّى سنة ١٢٩٤ ق) والحاج ملا محمد اندرماتى الطهراني (المتوفّى سنة ١٢٨٢ ق) وميرزا ابو القاسم كلانتر (المتوفّى سنة ١٢٩٢ ق) والشيخ محمد بن محمد العلى (ابن اخت صاحب الفصول) والحاج ملا هادى الطهراني (المتوفّى سنة ١٢٩٥ ق) والشيخ حسين بن محمد إسماعيل الأردكاني المعروف بالفاضل الأردكاني (المتوفّى سنة ١٣٠٢ او ١٣٠٥ ق) وملا زين العابدين گلپايگاني
(المتوفى سنة ١٢٨٩ ق) والحاج ملا عبد الهادي الطهراني. كان نتاج جهوده في مجال التعليم والتأليف أنّه ربّى تلاميذ عدّة كما ترك اكثر من ٢٠٠ تأليف في مجالات الفقه والأصول والحديث والأدب والمنطق والعقائد والعرفان والتفسير والتراجم والعلوم الغريبة.(١)
ففى الختام نشكر لحفيده الماجد حجة الإسلام حسين الشريف والذي وضع بين أيدينا المخطوطات الاصلية لهذه الكتب. وآخر دعوانا عن الحمد لله ربّ العالمين.
حسين درگاهى
__________________
(١) ومن يريد التفصيل يمكنه المراجعة الى هذه المصادر :
مجلّة «نور علم»، عدد ٥٤، صص ٢٣ ـ ٦٧، المقالة التحقيقية لحجّة الإسلام والمسلمين رضا الاستادى ؛ لباب الألباب في القاب الاطياب في ترجمه علماء كاشان للمؤلف نفسه ؛ ريحانة الأدب، ج ٥، صص ١٨ ـ ١٩ ؛ معجم لغات دهخدا تحت مدخل «حبيب الله بن على مدد»، او تحت عنوان «الكاشاني» ؛ عقايد الايمان في شرح دعاء العديلة، للمؤلف نفسه، مطبعة بصيرتى بقم، ١٣٦٩، المقدّمة ؛ منتقد المنافع، للمؤلف نفسه، ج ٤، طبع سنة ١٣٦٤ ش، في مقدمة تسمّى بـ «العقول النافع في ترجمة صاحب منتقد المنافع ؛ ترجمة ملا حبيب الله الشريف الكاشاني، لعلى الشريف (من أحفاد المؤلف) ؛ ذريعة الاستغناء في تحقيق مسئلة الغناء، للمؤلف، طبع في مركز احياء آثار الملا حبيب الله الشريف الكاشاني «فقيه فرزانه»، عبد الله موحد، مكتبة التبليغات الاسلامية في حوزة قم العلميّة، ١٣٧٦.
الأنوار السانحة في تفسير
سورة الفاتحة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الّذي علّم القرآن، خلق الإنسان، علّمه البيان، والصلاة على محمّد صاحب البرهان والتبيان، وآله أمناء الرحمن، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم العيان.
أمّا بعد فيقول الفقير إلى الله ابن علي مدد : إنّ هذه عجالة سمّيتها بـ «الأنوار السانحة في تفسير الفاتحة » وما يتعلّق به، وفيها مقدّمة وفصول.
[المقدّمة]
أمّا المقدّمة ففي نبذ من فضائل القرآن.
روي في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا جمع الله عزّ وجلّ الأوّلين والآخرين، إذا هم بشخص قد أقبل ليس صورة أحسن منه، فإذا نظر إليهم المؤمنون وهو القرآن، قالوا : هذا منّا، هذا أحسن شيء رأينا، فإن انتهى إليهم جازهم، ثمّ ينظر إليه الشهداء حتّى إذا انتهى إلى آخرهم جازهم، فيقولون : هذا القرآن، فيجوزهم كلّهم حتّى إذا انتهى إلى المرسلين، فيقولون : هذا القرآن، فيجوزهم ثمّ حتّى ينتهي إلى الملائكة، فيقولون : هذا القرآن، فيجوزهم ثمّ ينتهي حتّى يقف عن يمين العرش، فيقول الجبّار : وعزّتي وجلالي وارتفاع مكاني لأكرمنّ اليوم من أكرمك، ولأهيننّ من أهانك(١) .
أقول : إكرام القرآن هو العمل بما فيه من الأوامر والنواهي وقراءته صحيحة والمواظبة عليها، وإهانته هو نبذ أحكامه وحدوده تحت القدم بأن لا يراعى ما فيه، ولا يقرأ على طريق حسن، ولا يتدبّر في آياته. قال : لا خير في قراءة من لا يتدبّر فيها.
__________________
(١) الكافي ٢ : ٦٠٢.
وفي عدّة الداعي عنه عليه السلام أيضا : من استمع حرفا من كتاب الله من غير قراءة كتب الله له حسنة، ومحا عنه سيّئة، ورفع له درجة(١) .
وفيها أيضا : عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم : إذا ألبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنّه شافع مشفّع، وشاهد مصدّق، ومن قاده أمامه قاده إلى الجنّة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار(٢) .
أقول : المراد بلبس الأمور تعطيل الحدود والأحكام واختلاف الناس فيها، فحينئذ فليرجع إلى القرآن، فإنّه منبعها ومأخذها، ومنه يظهر الحلال والحرام، فلذا قال : إنّي تركت فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي ؛ لو تمسّكوا بهما لن تضلّوا من بعدي(٣) .
وفي مجمع البيان : عنه صلّى الله عليه وآله وسلّم : من قرأ الفاتحة فكأنّما قرأ ثلثي القرآن، وكأنّما تصدّق على كلّ مؤمن ومؤمنة، والّذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة والإنجيل والزبور ولا في القرآن مثلها، وهي امّ القرآن، والسبع المثاني، وهي مقسومة بين الله وبين عبده، ولعبده ما سأل، وهي أفضل سورة في كتابه، وهي شفاء من كلّ داء.
وفيه أيضا : عنه صلّى الله عليه وآله وسلّم : إنّه أفرد على الامتنان بها وجعلها بإزاء القرآن، فقال :( وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ) (٤) وإنّها أشرف ما في كنوز العرش، وإنّه تعالى خصّ محمّدا وشرّفه بها ولم
__________________
(١) عدّة الداعي : ٢٨٦.
(٢) الكافي ٢ : ٥٩٨.
(٣) كتاب سليم : ٧٩٠.
(٤) الحجر : ٨٧.
يشرك فيها أحدا من أنبيائه إلّا سليمان عليه السلام، فإنّه اعطي منها البسملة، ألا فمن قرأها معتقدا لموالاة محمّد وآله، منقادا لأمرها، مؤمنا بظاهرها وباطنها، أعطاه الله بكلّ حرف منه حسنة، كلّ واحد منها أفضل من الدنيا وما فيها من أصناف أموالها وخيراتها، ومن استمع إلى قارئ يقرأها كان له ثلث ما للقارئ.
أقول : يظهر من قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم «هي امّ القرآن والسبع المثاني» اختصاص المثاني بـ «الفاتحة»، لأنّها تثنّى في كلّ صلاة، وإلى ذلك ذهب المشهور.
وقيل : المثاني «هود» و «يوسف» و «رعد» و «إبراهيم» و «الحجر» و «النمل» و «يونس».
وقيل : يطلق على جميع القرآن(١) .
وفي الكافي : عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : أعطيت الطوال مكان التوراة، وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وأعطيت المثاني مكان الزبور، وفضّلت بالمفصّل(٢) .
أقول : المراد بالطوال على ما قاله بعض : «البقرة» و «آل عمران» و «النساء» و «المائدة» و «الأنعام» و «الأعراف» و «الأنفال» و «التوبة».
وقيل : «يونس» سمّيت بالطوال لأنّها أطول السور.
والمراد بالمئين : «بني إسرائيل» و «الكهف»و «مريم» و «طه» و «الأنبياء»
__________________
(١) مصباح الكفعميّ : ٤٣٨.
(٢) تفسير العيّاشي ١ : ٢٥.
و «الحجّ» و «المؤمنون» سمّيت بذلك، لكونها مشتملة على مائة آية أو فويق ذلك أو دوينه.
والمراد بالمفصّل : ما بعد «الحواميم» إلى آخر القرآن، سمّيت بذلك لكثرة الفصول بين سورها بالتسمية أو بين الآي. فتأمّل.
وفي قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : «وفضّلت بالمفصّل» إظهار لزيادة فضيلته صلّى الله عليه وآله وسلّم على الأنبياء من جميع الوجوه.
أمّا الفصول فثمانية.
الفصل الأوّل
في ما يتعلّق بالبسملة
وفيه جنّات.
الجنّة الاولى : في فضائلها وبعض ما يتعلّق بكتابتها
فنقول : الأخبار في فضلها كثيرة :
منها : ما روي من أنّ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) مفتاح كلّ باب ينزل من السماء.
وروي أيضا : إنّ «بسم الله» أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها(١) .
وروي : أنّه من قالها يتصاغر الشيطان كالذباب.
وعن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم : من قال( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ )
__________________
(١) تحت العقول : ٤٨٧، تفسير العيّاشيّ ١ : ٢١.
كتب الله له أربعة آلاف حسنة، ومحاعنه أربعة آلاف سيّئة، ورفع له أربعة آلاف درجة(١) .
وعنه صلّى الله عليه وآله وسلّم : لا يردّ دعاء في أوّله( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) فإنّ أمّتي يأتون يوم القيامة وهم يقولون( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) فتثقل حسناتهم في الميزان، فيقول الملائكة : ما رجّح موازين أمّة محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم؟ فيقول الأنبياء : إنّ ابتداء كلامهم «البسملة» وهي ثلاثة أسام من أسمائه تعالى ؛ لو وضعت في كفّة الميزان ووضعت حسنات الخلق في الكفّة الاخرى لرجحت «البسملة»(٢) .
والأخبار على نحو ذلك في فضيلة «البسملة» كثيرة تنافي وضع الإيجاز.
ونقل الكفعميّ في «الرسالة الواضحة» عن بعض العلماء أنّه قال : لمـــّـا كان الليل والنهار حال الاعتدال أربعا وعشرين ساعة، خمس ساعات منهنّ فرض الصلاة يقرأ فيهنّ «البسملة» بقي تسع عشرة ساعة يكفّر كلّ حرف منها ذنوب ساعة من تلك الساعات.
ونقل أيضا : إنّ الذنوب أربعة أنواع : ذنوب الليل، وذنوب النهار، وذنوب السرّ، وذنوب العلانية، والبسملة أربع كلمات ؛ فمن ذكرها على الإخلاص والصفاء غفر الله له تلك الأنواع الأربعة.
وقد روي : أنّ «البسملة» لمـــّـا نزلت على داوود، ألان له الحديد ونادته الملائكة : الآن يا داوود تمّ لك ملكك. انتهى.
__________________
(١) جامع الأخبار : ٤٢.
(٢) مجموعة ورّام : ٣٢.
ويظهر من بعض الأخبار ابتغاء البدأة بالبسملة في بدءة جميع الأمور، لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : كلّ أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر(١) . ولتوافق العبارة والكتابة مع الأعيان والأذهان، لأنّه تعالى سابق في هنا فناسب سبقه هناك، وللتأسّي بالقرآن وللتيمّن ؛ كذا قيل.
ونقل الكفعميّ أيضا عن الزمخشريّ أنّ زيد بن ثابت كان يكره أن يكتب البسملة بغير سين، وإذا رآها ليس لها سين محاها.
الجنّة الثانية : في إعرابها
فقوله تعالى :( بِسْمِ اللهِ ) ظرف حكميّ، وهل متعلّقه اسم كابتداء كلامي، أم فعل مقدّم كأبدأ أو أتصدّر كلامي باسم الله، أم فعل متأخّر أي بسم الله أقرأ في القراءة أو أحلّ في الفتح، أو غير ذلك ممّا يناسب الأمور؟ احتمالات : أوّلها للبصريّين، وثانيها للكوفيّين، ونسبه الأنصاريّ إلى المشهور في التفاسير والأعاريب، ونقل الرابع عن الزمخشريّ، وجملة البسملة في الأوّل اسميّة، وفي الأخير شعبيّة فعليّة، والظرف في الجميع مستقرّ.
قال الكفعميّ : قيل : إنّ الباء في «بسم الله» للاستعانة ومعنى ذلك أبتدئ مستعينا.
وقال الطبرسيّ : الباء متعلّقة بمحذوف تقديره «بسم الله أقرأ».
وحكى عن بعض : أنّ المحذوف عند البصريّين مبتدأ والمجرور خبره،
__________________
(١) تفسير الإمام العسكريّ : ٢٥.
والتقدير : ابتدائي باسم الله أي كائن، فـ «الباء» متعلّقة بالكون والاستقرار.
وعند الكوفيّين فعل تقديره «ابتدأت أو أبدأ» فالمجرور في موضع نصب بالمحذوف، وحذفت الألف من الخطّ لكثرة الاستعمال، فلو قلت : لاسم الله أو باسم ربّك، أثبتّ الألف في الكتابة. انتهى.
وإضافة «الاسم» إلى «الله» لاميّة إن غاير الاسم والمسمّى، وبيانيّة إن اتّحد. فتأمّل، وسيأتيك التفصيل.
وإن أردنا من «الله» لفظه من غير إرادة المفهوم والمعنى فالإضافة حمليّة أيضا، وقوله «الله» مجرور بالإضافة وهي عامل معنويّ أو بالمضاف أم بالحرف المقدّر على اختلاف الأقوال، وثانيها هو المختار لأرجحيّة المذكور عند التعارض وغير ذلك، وجرّ «الرحمن» و «الرحيم» تبعيّ إن أثبتناه، والقطع قول مشهور.
الجنّة الثالثة : في بيان اشتقاق الاسم
اعلم أنّه قد اختلف في اشتقاق الاسم : فقال البصريّون : إنّه اشتقّ من السموّ أصله سمو، وحذفت الواو وزيد الألف معوّضة عنها كما في «ابن».
وقيل : ويشهد له تصريفه على أسماء وأسام. انتهى.
ومعنى السموّ هو العلوّ والرفعة، وبالاسم يرفع المسمّى.
وقال الكوفيّون : إنّه من الوسم ؛ أي العلامة، لأنّه دالّ على المسمّى وهو علامته، وأجيب بأنّ المحذوف «الفاء» كـ «صلة» و «عدة» لا تدخله همزة الوصل وبالتصغير.
أقول : الحقّ قول البصريّين، وإليه ذهب الجمهور من المتقدّمين والمتأخّرين، لكن يحتمل ضعيفا أن يقال : إنّ في الاسم النحويّ وجهين، وفي البسملة ونحوها يتعيّن اشتقاقه من الوسم. فتأمّل.
الجنّة الرابعة : في الفرق بين الاسم والمسمّى والتسمية
قد تشاجر الأصحاب في اتّحاد الثلاثة وتغايرها على أقوال ؛ الأوّل : إنّ الاسم نفس المسمّى نظرا إلى أنّ الله كان له في الأزل أسماء فهي قديمة بل عين الذات، وإلّا ليلزم تعدّد القدماء. وبطلانه ظاهر.
وإلى قوله تعالى :( فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ ) (١) فلو لم يكن الاسم نفس المسمّى لما صحّ التسبيح، لأنّه خاصّ بذات الباري، وكذا قوله :( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) (٢) .
وإلى قوله :( ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْماءً سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ) (٣) ولا يخفى أنّهم ما كانوا عابدين للألفاظ، بل للمسمّيات.
والجواب عن الجميع مجملا يظهر ممّا سيجيء.
ومن أنّكم لو أردتم من الاسم هو الذات فهذا أوّل الكلام، بل لا يطلق على المسمّى أصلا إلّا على وجه الكناية كما ستعلم، فلا نسمع أن يقال : جاء اسم زيد أو رأيت عمروا اسمه مريدا للذات، ولو أردتم به الحروف
__________________
(١) الواقعة : ٧٤، ٩٦، الحاقّة : ٥٢.
(٢) الأعلى : ١.
(٣) يوسف : ٤٠.
الملفوظة فالتغاير أظهر من الشمس لما تفهم، وإن أردتم به الصفة فلا يخفى أنّ جميع صفات الله ليست ذاتيّة، فالإطلاق غير حسن، وسيأتيك تفصيل عن قريب.
والجواب عن الأوّل مفصّلا : إنّ قدم الأسماء الملفوظة غير مسلّم، بل هي حادثة بالنصّ والإجماع، ولأنّها متفاوتة بتفاوت اللغات كالعربيّ والعجميّ، فلو كانت عين المسمّى لزم تغيّر الذات وتفاوته بها مع أنّ الذات محض وحدة لا يتطرّق إليه الكثرة، ولو كانت عينه لزم تعدّد الآلهة، لأنّ لله عزّ وجلّ تسعة وتسعين اسما كما في العدّة عن الرضا عليه السلام، مع أنّ العين واحدة وليس إلّا معنى واحد جامع للمعاني.
فإن قيل : فما معنى قولهم : كان هو العالم القدّوس في الأزل وغير ذلك من الأسماء المختلفة؟
قلنا : قد بيّن في الكتب الكلاميّة أنّ الصفات الذاتيّة الّتي ترجع إلى الذات عين الذات، بمعنى أنّه عين واحدة جامعة للجميع ؛ فهي قادرة بعلم، وعالمة بقدرة وغير ذلك، أي : مفهوم الكلّ في الحقّ واحد يعلم بقدرته ويرى بعلمه، وقيّوم بحيويّة وحيّ بقيموميّة، والأخبار على ذلك أيضا شاهدة، ومعنى أنّه تعالى كان في الأزل عالما قادرا قدّوسا أنّه تعالى كان في الأزليّة الأولى متّصفا بتلك الصفات من غير وجود ما يظهرها من حجابها العينيّ إلى اللفظيّ، بل الذهنيّ الحادثين، فليس المراد من كون الأسماء في الأزل، كون الألفاظ ؛ بل معانيها الّتي ترجع إلى معنى واحد من جميع الوجوه، وهو نفس الذات وعينه، بل لا يحسن القول بأنّ تلك أسماء وأوصاف له، بل ليس
للحقّ صفات وهو الذات البحت والوجود المطلق، فلذا قال عليّ عليه السلام : كمال التوحيد نفي الصفات عنه(١) . انتهى.
ولا خلاف بين الإماميّة في أنّ الصفات الذاتيّة عين الذات، وأنّها واحدة، وأنّ الحقّ كان متّصفا بها في الأزل، وإنّما الخلاف في أنّ الله تعالى هل كان في الأزل متّصفا بالخلّاقيّة والرزّاقيّة وغير ذلك ممّا يتوقّف على وجود آخر؟
فقال بعض : إنّ تلك الصفات منتفية عنه تعالى في الأزل نظرا إلى أنّ الخلق يستلزم المخلوق مثلا، فيلزم تعدّد القدماء.
وقال آخرون : إنّها كانت ثابتة له تعالى نظرا إلى أنّ معنى الخالق والمتكلّم مثلا هو القدرة على الخلق والتكلّم، ولا يستلزم الإثبات الفعليّة ؛ إذ القوّة كافية في إثبات صفة لشيء، لأنّك تطلق على السيف أنّه قاطع مع أنّه في الغمد، والمعنى أنّه قاطع بالقوّة ؛ بمعنى أنّه متّصف بتلك الصفة عند ملاقاة المحلّ، وهو تعالى خالق ومتكلّم في الأزل، أي : قادر على ذلك عند إرادة الخلق والتكلّم.
بل نقول : إنّ صفة الكلام والخلق والرزق ونحوها داخلة في القدرة الّتي هي من صفات الذات، فللأسماء إطلاقان : قديمة من وجه، وحادثة من وجه ؛ فإطلاق القول بأنّ الاسم نفس المسمّى غير وجيه، وهنا أبحاث كثيرة تنافي الموجز.
والجواب عن الثاني : أوّلا إنّ الاسم في تلك المواضع زائدة للتوكيد
__________________
(١) التوحيد : ٥٦.
ك «الكاف» في قوله :( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) (١) وقول الشاعر : «اسم السلام عليكما»(٢) مؤيّد لذلك.
وثانيا : بأنّ الخلق لا يوصل فهمهم إلى ذات الباري، فلا يدركه وهمهم، مع أنّ في العبادة والتسبيح يشترط معرفة المعبود والمسبّح، فيكفي للخلق معرفة الاسم أي الصفة وعبادة الذات المجملة في تلك الصفة المعلومة.
وثالثا : بأنّ الاسم في تلك كنايه عن الذات لإجلاله وإعظامه ؛ كما يقال : أدركت فيض حضرة زيد مثلا، والسلام على حضرته أي عليه.
ورابعا : بأنّ المراد من تسبيح الاسم ليس عبادته المذمومة في الأخبار ؛ كما سيجيء بعضها، بل المراد تنزيه الاسم عن السوء، وعن مشابهة أسماء العباد، لأنّ ذكره تعالى أجلّ الأذكار، واسمه أعظم الأسماء، والأدعية على ذلك شاهدة.
والجواب عن الثالث : إنّ العادة قد جرت في إطلاق الاسم من غير المسمّى على من سمّي باسم ولم يكن متّصفا بمدلوله ؛ كما إذا سمّي الرجل بالجواد مع أنّه بخيل فيقال : إنّ ذلك الرجل له اسم من غير معنى، فإطلاق الآلهة على الأصنام كإطلاق اسم على رجل من دون وجود معناه في العين، فمعنى الآية إنّ الالوهيّة معنى يخصّ الحقّ تعالى لا يوجد في غيره، وإطلاقها على سواه اسم من غير وجود معناه : وما تعبدونه من دون الله إلّا
__________________
(١) الشورى : ١١.
(٢) تمام البيت :
إلى الحول ثمّ اسم السلام عليكما |
ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر |
وهو للبيد. انظر : مجمع البيان، المجلّد ١ : ٩٢ ـ ٩٣.
الأسماء الّتي ليست لها معاني في حقّ المسمّيات.
القول الثاني : إنّ الاسم نفس التسمية وغيره.
وجوابه يظهر ممّا سيجيء ؛ من أنّ التسمية هي ذكر الاسم ووصفه والتلفّظ به.
القول الثالث : إنّ الاسم غير المسمّى والتسمية، بل هي أسماء متباينة مختلفة المعاني. وهو قول الأكثر، وتبعهم الغزاليّ في كتاب «كشف وجوه الغرّ» ولهم وجوه.
منها : ما روي من : أنّه من عبد الله بالتوهّم فقد كفر، ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك(١) إلى آخره. وهذا صريح في التغاير المدّعى.
ومنها : ما روي من : أنّ لله تسعة وتسعين اسما من دعا بها استجيب له، ومن أحصاها دخل الجنّة(٢) . انتهى.
وهذا أيضا يؤيّد التباين ؛ إذ يلزم على فرض عدمه تعدّد الآلهة، فيصير المعنى : أنّ لله تسعة وتسعين ذاتا.
وروي أيضا من : أنّ الله جعل أسماءه أربعة أجزاء، أظهر منها ثلاثة لفاقة الخلق إليها، وحجب الاسم الأعظم المكنون المخزون، وجعل لكلّ اسم من الأسماء الظاهرة أربعة أركان، ولكلّ ركن ثلاثين اسما ؛ فالأركان اثنا عشر،
__________________
(١) الكافي ١ : ٨٧.
(٢) مصباح الكفعميّ : ٣١٢.
والأسماء ثلاثمائة وستّون اسما(١) . انتهى. وغير ذلك من الأخبار كثير.
ومنها : ما ذكره الغزاليّ في «الكشف» وهو الذيل لكنّ حاصله : إنّ الحقّ تغاير الاسم والمسمّى والتسمية، وإنّ هذه ثلاثة أسماء متباينة غير مترادفة. وقال : لا سبيل إلى كشف الحقّ إلّا ببيان معنى كلّ واحد من هذه الألفاظ الثلاثة منفردا، ثمّ بيان معنى قولنا : هو هو، ومعنى قولنا : هو غيره، فهذا منهاج الكشف للحقائق، ومن عدل عن هذا لم ينجح أصلا، فإنّ كلّ علم تصديقيّ ـ أي المتطرّق إليه الصدق والكذب ـ فإنّه لا محالة قضيّة تشتمل على موصوف وصفة ونسبة تلك الصفة إلى الموصوف، فلا بدّ أن يتقدّم عليه المعرفة بالموصوف وحده على سبيل التصوّر لحقيقته، ثمّ المعرفة بالصفة وحدها، ثمّ النظر في نسبة الصفة إلى الموصوف أنّها موجودة له أو منتفية عنه ويسمّى بالنسبة الحكميّة.
فنقول في بيان حدّ الاسم وحقيقته : إنّ للأشياء وجودا في الأعيان، ووجودا في الأذهان، ووجودا في اللسان ؛ أمّا الوجود في الأعيان فهو الوجود الأصليّ الحقيقيّ الشخصيّ الخارجيّ، والوجود في الأذهان هو الوجود العلميّ التصوّريّ، والوجود في اللسان هو الوجود التلفّظيّ الدليليّ، فإنّ السماء مثلا لها وجود في عينها ونفسها وهي الوجود المشهود الخارجيّ، ثمّ لها وجود في أذهاننا ؛ إذ صورتها منطبعة في أبصارنا أوّلا، ثمّ في خيالنا بحيث لو عدمت السماء وبقينا لكانت صورتها حاضرة في خيالنا بالقوّة الدرّاكة، وهذه الصورة هي الّتي يعبّر عنها بالعلم، وهي مثال ومحك
__________________
(١) مصباح الكفعميّ : ٣١٢.
وموازن للمعلوم الخارجيّ كحكاية المرآة عن الصورة المقابلة لها الخارجة عنها، لكنّها مطابقة لها.
وأمّا وجود «السماء» باللسان فعبارة عن تلفّظها به المركّب من الأصوات المقطوعة يعبّر عن التقطيع الأوّل بالسين، وعن الثاني بالميم، وعن الثالث بالألف، وعن الرابع بالهمزة، فيقال : سماء. وإذا كتبت على صحيفة فلها وجود كتابتيّ، فاللفظ آخر المراتب وهو خال عن الذهن، ودليل عليه، والذهن أوسطها وهو خال عن العين الحقيقيّة ومطابق لها، بل لو لم يكن الوجود العينيّ لم تنطبع في الذهن، ولو لم يكن الذهنيّ لم يشعر به الإنسان، فيعبّر عنه باللسان.
فظهر أنّ الأوّل يسمّى بالمعلوم الحقيقيّ، والثاني بالعلم، والثالث باللفظ، وهي ثلاثة أمور متباينة ولكنّها متطابقة ومتوازية، وكيف لا تكون متغايرة مع أنّ لكلّ خواصّ ليست للآخر ولا يلحقه.
فإنّ الإنسان مثلا يلحقه النوم واليقظة والحياة والممات والمشي وغير ذلك باعتبار وجوده العينيّ، ويلحقه الابتدائيّة والخبريّة والعموم والخصوص والجزئيّة والكلّيّة ونحو ذلك باعتبار وجوده الذهنيّ، ويلحقه العربيّة والعجميّة والتركيّة والحقيقة والمجاز والإطناب والإيجاز والاسميّة والفعليّة والحرفيّة ونحوها باعتبار الوجود اللفظيّ، وهذا الوجود يختلف باختلاف الأعصار، ويتفاوت بتفاوت عادة أهل الأمصار، وأمّا الأوّلان فلا يختلفان أبدا.
وقد علمت أنّ الألفاظ عبارة عن الحروف المقطّعة الموضوعة باختيار
الإنسان للدلالة على الأعيان، وموضوعها إمّا أوّليّ كقولك : سماء، شجر، ونحو ذلك، وإمّا ثانويّ كقولك : اسم، فعل، حرف، فإذا قيل لنا : ما حدّ الاسم؟ قلنا : إنّه اللفظ للدلالة على معنى مستقلّ، فالغرض من الاسم هو المرتبة الثالثة من الوجود، وهي الوجود اللسانيّ.
إذا علمت ذلك فاعلم أنّ كلّ لفظ موضوع للدلالة، فله واضع، وآلة وضع، وموضوع له. يقال للواضع : «المسمّي» بكسر الميم، وفي الواضع أقوال ليس هذا [محلّ ذكرها]. وللوضع : «التسمية» فيقال : سمّى فلان ولده : إذا وضع له اسما يدلّ عليه، وللموضوع له : «المسمّى» بفتح الميم.
فيجري الاسم والتسمية والمسمّي والمسمّى مجرى الحركة والتحريك والمحرّك والمحرّك، وهذه الأسماء الأربعة أسام متباينة تدلّ على معان مختلفة، فالحركة على النقل من مكان إلى آخر، والتحريك على إيجاد هذه الحركة، والمحرّك على فاعلها، والمحرّك على الشيء الّذي فيه الحركة مع كونها صادرة عن فاعل لا كالمتحرّك الّذي لا يدلّ إلّا على المحلّ الّذي فيه الحركة ولا يدلّ على الفاعل.
فإذا ظهر الآن مفهومات هذه الألفاظ، فلينظر هل يجوز أن يقال فيها إنّ بعضها هو البعض؟
وقال أيضا ما حاصل كلامه : إنّ قولنا : هو هو، بحمل شيء على شيء حمل الهويّة، له معان ثلاثة :
الأوّل : إنّ هذين الشيئين متّحدان في الحقيقة والمفهوم على وجه الكلّيّة والتصادق الكلّيّ، بمعنى أنّ نفي أحدهما هو نفي الآخر، ويسمّى ذلك
بالمترادفين لإرداف كلّ منهما في معنى واحد وإن اختلف حروفهما ؛ كما يقال : البشر هو الإنسان، والخمر هي العقار، والليث هو الأسد.
الثاني : إنّ هذين متّحدان في بعض الوجوه من غير تصادق كلّيّ كالإنسان والحيوان، والسيف والصارم، والمهنّد والسيف.
الثالث : إنّ هذين متّحدان في المحلّ ؛ كما يقال : الثلج أبيض بارد، والأبيض هو البارد، ومعنى ذلك أنّ العين الواحدة قد اتّصفت بالبياض والبرودة.
إذا علمت ذلك، فاعلم أنّ بهذا يردّ القول بالاتّحاد ؛ وتوضيح ذلك : إنّ قولكم : الاسم هو المسمّى، لو أردتم به حمل الهويّة بمعنى الأوّل كما هو أظهر الوجوه، فقد ثبت أنّ الاسم هو اللفظ، والمسمّى هو المدلول، وأنّ الاسم يختلف بالعربيّة والعجميّة دون المسمّى، وأنّ السؤال بالاسم يقع «ما هو» دائما دون المسمّى، فإنّه قد يقع «من هو» كما إذا حضر شخص فقيل : ما اسمه؟ فيقال : زيد، وإذا سئل عن مسمّاه وحقيقته قيل : من هو؟ وقد يسمّى الحسن الجميل التركيّ بالهنود، فيقال : مسمّى حسن، واسم قبيح، ويسمّى الخفيف باسم كثير الحروف، وثقيل المخارج، قيل : اسم ثقيل، ومسمّى خفيف، والاسم قد يكون مجازا دون المسمّى، والاسم قد يتبدّل على سبيل التفاؤل والتطيّر ولا يتبدّل المسمّى.
فهذا كلّه يعرّفك أنّ الاسم غير المسمّى، ولو تأمّلت وجدت فروقا غير ذلك، لكنّ البصير يكفيه اليسير، والبليد لا يزيده التكثير إلّا التحيير.
ولو أردتم به المعنى الثاني فقلتم : إنّ الاسم عين المسمّى بمعنى أنّه
داخل فيه ومشتقّ منه يلزم اتّحاد التسمية معهما أيضا، لأنّ الكلّ مأخوذ من الاسم، فيلزم اتّحاد المتحرّك والحركة والتحريك والتحرّك والمحرّك والمتحرّك ؛ إذ الكلّ مأخوذ من الحركة، مع أنّ ذلك الحمل لا يصحّ وقوعه فيها ؛ إذ هي ليست كالسيف والصارم والمهنّد، لأنّ السيف صارم عند صفة، وكذا مهنّد عند اخرى، والاسم دلالة، والمسمّى مدلول، والتسمية وضع، وليست التسمية اسما بصفة، وكذا البواقي، فالحمل غير صحيح.
ولو أردتم به المعنى الثالث، فقياس الثلاثة عليه أيضا باطل، لفقدان الوجه الجامع ؛ إذ ليس هنا شيئا موضوعا قد يتّصف بالاسم وقد يسمّى بالتسمية، كالثلج ؛ إذ هو معنى واحد موضوع موصوف بالبرودة والبياض.
هذا توضيح ما قاله الغزاليّ ومحصّله.
لكن أنا أقول : الحقّ في المسألة على ما خطر ببالي أنّه إن أريد من الأسماء معاني الصفات الذاتيّة الّتي فيها وسم الذات فهي عين المسمّيات ؛ إذ ثبت في محلّه أنّ صفاته تعالى عين ذاته، فلذا قيل : الصفات غير الذات من حيث ما تفهم العقول، وعينه من حيث التحقّق والحصول.
وإن أريد منها حروفها المقطوعة فغير المسمّيات، للأدلّة المذكورة، مثلا العالم عين الذات الواحدة بالنظر إلى معناه وحقيقته الّتي هي الاتّصاف بالعلم المتّحد مع القدرة وسائر الصفات الذاتيّة، وغير الذات بالنظر إلى لفظه ؛ إذ من الضروريّات أنّ العين والألف واللام والميم ليست عين الذات.
وقد قيل : إنّ الصفات غير الذات من حيث إنّ مفاهيهما متغاير للآخر بالنظر إلى الظاهر، وعينها من حيث إنّ الذات جامع لجميعها، فيقدر بعلمه
ويعلم بقدرته، وذلك معنى إيقاع الأسماء عليه إلى آخره. وهذا معنى ما قيل [أنّ] الصفات غير الذات من حيث ما تفهم العقول، وعين الذات من حيث التحقّق والحصول.
وكذا يغاير الاسم والمسمّى إن أريد من الاسم الصفات الفعليّة.
إذا علمت ذلك، فاعلم أنّ الظاهر هو عدم القول بأنّ الاسم عين المسمّى بمعنى كون لفظه عين الذات، لأنّ ذلك ممّا لم يقل به البليد، فكيف يقوله الفطين الحميد! فنسبة ذلك القول إلى بعض العلماء وعدّه في الأقوال خطأ، فتدوين الأدلّة في الردّ على ذلك بما يناسب اللفظ بأن يقال الاسم هو الحروف، فكيف يكون عين المسمّى عجيب، بل ذكر ذلك عن مثل الغزاليّ غريب غاية العجب والغرابة ؛ إذ مراد القائلين بالعينيّة ليس إلّا ما ذكرنا، وهو مذهب الإماميّة.
وأمّا بعض أهل الجماعة زعموا أنّ الصفات غير الذات، بمعنى أنّ الذات شيء والوصف شيء آخر، ويلزم على ذلك تعرّي الذات عن تلك الأوصاف في الأزل إن لم تكن معه فيه وتعدّد القدماء واحتياج القديم إليها إن كانت.
على أنّ الأخبار متواترة على ردّ ذلك وناصّة على العينيّة. وهنا أبحاث كثيرة، وتفاصيل غير يسيرة ؛ ليس هذا الكتاب موضع ذكرها.
فرع :
قالت الوحدتيّة من الصوفيّة لعنهم الله : إنّ المراد بالصفات والأسماء هو الموجودات كلّها، لأنّها مظاهر الحقّ، بل هي على صورته ومرآة لذاته، فهي الشؤونات الذاتيّة.
حسن ازل برگرفت پرده رخسار خويش |
صورت اعيان عيانساخت به اظهار خويش |
|
كرد عيان هستيش آئينه نيستى |
گشت در آن آئينه ناظر ديدار خويش |
|
تادروجود كن فكانحسن صفات آمد پديد |
در جسم وجانها پرتوى ازنورذات آمد پديد |
|
يك لمعه از نور رخش افتاد بر كتم عدم |
چندان هزاران آئينه در كاينات آمد پديد |
فمرادهم من أنّ الصفات عين الذات والأسماء نفس المسمّيات، هو أنّ الخلق نفس الحقّ أي حقيقتها متّحدة كاتّحاد القطرة مع البحر، فسبحان الّذي أظهر الأشياء وهو عينها.
اى كاينات، ذات تو را مظهر صفات |
وى پيش اهل ديده، صفات تو عين ذات |
|
يا أشمل المظاهر ويا أكمل الظهور |
يا برزخ البرازخ، يا جامع الشتات |
|
گر سوى تو سلام فرستم، توئى سلام |
گربر تو من صلات فرستم، توئى صلات |
|
هم درد وهم دوائى، هم حزن وهم فرح |
هم قفل وهم كليدى وهم حبس وهم نجات |
هم گنج وهم طلسمى وهم جسمىوهم روان |
هم اسمى وهم مسمّى وهمذات وهم صفات |
|
هم مغربيّ مغرب وهم مشرقىّ مهر |
هم عرش وفرش عنصر وأفلاك وهم جهات |
|
اگر ز پيش تو برخيزد اين حجاب صفات |
مثال قطره به دريا تو گم شوى در ذات |
|
آنم كه نيست در نظرم هيچ غير ذات |
گر در حرم گذار كنم ور بسو منات |
|
ديريست كز صفات گذشتم ولى كنون |
من عين ذات اويم وعالم مرا صفات |
وأمثال تلك المزخرفات الباطلة الواهية قد كثرت من الوحدتيّة الخبيثة ؛ ذكرنا بعضها في «توضيح السبل» وغيره.
خاتمة :
الاسم الأعظم اسم هو أعظم الأسماء وأعلا محلّا منها، بل إمامها، ولذلك تسمّيه الصوفيّة بأمّ الأسماء.
وقال بعضهم : الاسم الأعظم اسم جمع فيه فوائد جميع الأسماء وهو «الله» ويسمّى باسم الجامع.
وقال بعض : الاسم الأعظم هو الإنسان الكامل، لأنّه جامع لجميع الأسماء.
وفي مصباح الكفعميّ عن الصادق عليه السلام : إنّ الاسم الأعظم في «فاتحة الكتاب» وإنّها لو قرئت على ميّت سبعين مرّة ثمّ ردّت فيه الروح ما كان ذلك عجبا(١) .
وفيه عنه عليه السلام : من بسمل وحولق بعد صلاة الفجر مائة كان [أقرب] إلى الاسم الأعظم من سواد العين إلى بياضها، وإنّه دخل فيها اسم الله الأعظم(٢) .
وفي بعض الأخبار عنه عليه السلام : إنّه البسملة.
وادّعى الكفعميّ وفاق جميع الأخبار على أنّ «لا إله إلّا هو» اسم الله الأعظم.
وعنه عليه السلام أنّه قال لبعض أصحابه : ألا أعلّمك الاسم الأعظم؟
قال : بلى. قال : اقرأ «الحمد» و «التوحيد» و «آية الكرسيّ» و «القدر» ثمّ استقبل القبلة وادع بما شئت.
وعن عليّ بن الحسين عليهما السلام : إنّه في هذا : «اللهمّ إنّي أسألك باسمك يا الله يا الله يا الله، الله لا إله إلّا هو ربّ العرش العظيم».
والأخبار في الاسم الأعظم متواترة، بل مختلفة، ذكر بعضها إبراهيم الكفعميّ في «المصباح» وغيره في غيره.
__________________
(١) مصباح الكفعميّ : ٣٠٨.
(٢) مصباح الكفعميّ : ٣٠٨.
الجنّة الخامسة : في بيان بعض ما يتعلّق بالاسم الأعظم «الله»
وهنا مخازن.
المخزن الأوّل : في بعض ما يخصّ «الله» به دون سائر الأسماء
فنقول : وخصائصه إمّا متعلّقة بالنظر إلى الظاهر، وإمّا بعلم الحروف والجفر.
أمّا الخصائص الظاهريّة فكثيرة غير محصيّة ؛ ذكر بعضها الكفعميّ في «المصباح».
منها : إنّه أشهر الأسماء وأعلاها.
منها : إنّه لا يتشرّف الكافر بالإسلام إلّا به، فلو قال : «لا إله إلّا الرحيم» مثلا بدل «لا إله إلّا الله» لم يسلم، ولم يحقن دمه وماله وعياله وعرضه.
منها : إنّ جميع الأسماء ينسب إليه لا بالعكس، فيقال : «الرحمن» اسم من أسماء «الله» ولا يقال «الله» اسم من أسماء «الرحمن».
منها : إنّه لا يطلق على غيره تعالى، ويؤيّده قوله :( هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ) (١) فلا يقال شيء إله، بل قد يقال شيء حيّ مثلا.
منها : إنّه اسم الذات، ويؤيّده الشهرة، وسيأتيك التفصيل.
منها : إنّه أكثر الأسماء ذكرا في القرآن والدعوات والأذكار وغيرها.
منها : إنّه جامع لجميع فوائد الأسماء بحيث لو دعي به وقيل : «يا الله»
__________________
(١) مريم : ٦٥.
فكأنّما دعي بجميعها وقيل : يا رحمن، يا رحيم، يا صبور، يا شكور، يا ربّ إلى آخرها.
منها : إنّه متضمّن لفوائد دنيويّة واخرويّة ليست في غيره منها.
منها : إنّه لا يقع صفة وتابعا لبواقي الأسماء، فلا يقال : «الرحمن الله» بل يقال «الله الرحمن» مثلا، وهذا من أعظم المؤيّدات في كونه اسما للذات. فليتأمّل.
وأمّا الخصائص الباطنيّة فكثيرة أيضا :
منها : ما ذكره الكفعميّ في «المصباح» نقلا عن محمّد بن طلحة، أنّ الجلالة تدلّ على التسعة والتسعين اسما، لأنّك إذا قسّمتها في علم الحروف على قسمين كان كلّ قسمة ثلاثة وثلاثين، فنضرب الثلاثة والثلاثين في أحرفها بعد إسقاط المكرّر وهي ثلاثة يكون عدد الأسماء الحسنى(١) .
أقول : علماء الحروف لا يحسبون الحرف الملفوظيّ من غير كتابة، فلذا أسقطوا عن العدّ في «الله» الألف المتوسّطة والتشديد في حكم الكتابة.
ومنها : ما ذكره أيضا وهو أنّه لو أخذت من طرفي الجلالة ستّة ؛ ثلاثة من أحدهما ومثلها من الآخر وأعطيت لكلّ واحد من الحروف الأربعة قسمته وهي واحد ونصف، وتضرب القسمة في عدد الجلالة وهو ستّة وستّون يصير تسعة وتسعين.
منها : ما ذكره أيضا نقلا عن «المشارق» : إنّ «الله» يدلّ على أنّ الأشياء منه وبه وإليه وعنه وهو إلهها، لأنّك إذا أخذت منه «الألف» بقي «لله» «ولله كلّ
__________________
(١) مصباح الكفعميّ : ٣١٦.
شيء» «ولله ملك السماوات والأرض» فإذا أخذت اللام الواحدة دون الألف بقي «إله» «وهو إله كلّ شيء» فلو أخذت الألف أيضا بقي «له» «وله كلّ شيء» «وله الملك» ولو أخذت أيضا اللام الثانية يبقى «الهاء» المضمومة فيشبع فيصير «هو» «فهو الله وحده لا شريك له» و «هو» لفظ يوصل إلى ينبوع العزّة، ولفظ «هو» مركّب من حرفين و «الهاء» أصل و «الواو» فرع، فهو حرف واحد يدلّ على الواحد الحقّ و «الهاء» أوّل المخارج و «الواو» آخرها «هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن».
أقول : لو جمع «الله» مع «لله» كما في الصورة الاولى يصير «الله لله» أي ما عرف الذات إلّا الذات، فمعرفة الحقّ بكنهه مختصّ به تعالى، ولو جمع مع «له» كما في الصورة الثالثة يصير «الله له» فمعناه كذلك، بل هو موافق لعدّ أمين ؛ كما في قوله :( أَنَا لَكُمْ ناصِحٌ أَمِينٌ ) (١) .
ومنها : أنّه لو بسط «اللام» من الجلالة بالبسط البدايتيّ بالعدد الصغير يصير ثمان وسبعين، وهو موافق مع عدد «حكيم».
والبسط البدايتيّ عبارة عن أخذ عدد الحرف في رتبته مع عدد الحروف المتوسّطة حتّى ينتهي إلى الألف، مثلا «اللام» واقع في المرتبة الثانية عشرة بالعدد الصغير، فخذ عددها الاثني عشر مع عدد الحروف المقدّمة عليه وهو ستّة وستّون الموافق لعدد الجلالة. وقس على ذلك الكبير ؛ بأن تأخذ «اللام» في مرتبة الثلاثين والكاف في العشرين وهكذا، لكن «اللام» حينئذ موافقة مع عدد «العادل».
__________________
(١) الأعراف : ٦٨.
ومنها : أنّه لو أخذ عدد أصل الجلالة وهو «إله» الّذي عدّه ستّ وثلاثون مع عدّ مكرّرها الّذي هو ستّ وستّون يصير مائة واثنان، وهو موافق مع عدد «الأعلى» في قوله :( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) (١) .
ومنها : أنّه لو وضع من التهليل جميع المكرّرات لما بقي إلّا أصل الجلالة.
ومنها : أنّه لو عكس «الله» يصير «هللّا» ثنيّة أمر لمحمّد وعليّ عليهما السلام، لكونهما مسبّحين قبل المسبّحات.
ومنها : أنّه لو بسط بالبسط البدايتيّ لكان عدده مائة وثلاثة وسبعين مع الألف الملفوظة، وعدده موافق مع عدد( مُلْكٍ لا يَبْلى ) (٢) .
ومنها : أنّه يستخرج منه كلمة «التهليل» بأسرها وذلك بعد عكس الألف واللام الاولى، فيصير «لا» فإذا جمع معه الباقي يصير «لا إله» وإذا كسر الألف وجمع مع لفظ الله يصير «لا إله إلّا الله» وللجلالة حقائق كثيرة يحتاج بيانها إلى وضع كتاب على حدة.
خاتمة :
قال الكفعميّ : ذكر «الله» ضحى وعصر أو في الثلث الأخير من الليل ستّة وستّين مرّة بغير ياء يوصل إلى المطلوب(٣) .
__________________
(١) الأعلى : ١.
(٢) طه : ١٢٠.
(٣) مصباح الكفعميّ : ٣٦٣.
المخزن الثاني : في بيان اشتقاق الجلالة وذكر الخلاف وما يتعلّق بذلك
فنقول : قد تشاجر المتشاجرون في جمود الجلالة وعدم المبدأ لها وفي اشتقاقه، فمال فرقة كالخليل ومن حذا حذوه إلى الأوّل، فلعلّ نظرهم إلى أغلبيّة الجمود في الكلمات، فالحمل على الأغلب أغلب، وإلى أصالة عدم الاشتقاق، وقالوا : ليس يجب في كلّ لفظ الاشتقاق وإلّا لتسلسل.
ومال الجمّ الغفير وهو مذهب الكثير إلى الثاني نظرا إلى أنّ أكثر الأسماء الإلهيّة مشتقّ، بل الكلّ كذلك، فالحمل عليه هو المتعيّن ؛ وفيه نظر ؛ إذ الأسماء كلّها سوى الجلالة صفات، والاشتقاق لا ينافي الوصفيّة بخلافها، لكن الحقّ عندي اشتقاقه لما روي في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال : يا هشام «الله» مشتقّ من إله، والإله يقتضي مألوها(١) إلى آخره. فيردّ ذلك أصالة العدم المذكورة وغيرها ممّا استدلّ به النافون.
وكذا الخلاف في سريانيّها وعربيّها، والثاني هو المشهور.
وكذا اختلف القائلون بالاشتقاق على أقوال كثيرة حتّى قيل : كادت الأقوال أن تبلغ أربعة وعشرين :
منها : أنّه من «أله» إذا تحيّر لتحيّر العقول في كنه معرفته، وأله الخلق في درك مائيّته أي تحيّر.
ومنها : أنّه من «لاه» أصله «ليه» أي خفي وغاب، فهو إله ؛ أي مستور عن الأبصار، ومخفيّ عن الأنظار، فقصر عن رؤيته أبصار الناظرين، وبصر
__________________
(١) الكافي ١ : ٨٧، التوحيد : ٢٢٠.
البصير، ونظر النظير( لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَهُوَاللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ) (١) ومنه :
لاه ربّي عن الخلائق طرّا |
خالق الخلق لا يرى ويرانا |
ومنها : أنّه من «الألوهة» وهي العبادة، يقال : ألهه ألوهة أي عبده عبادة.
قيل : حكي عن ابن مسعود وابن عبّاس أنّهما قرءا :( وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ ) (٢) أي عبادتك.
قال في القاموس : أله إلهة وألوهة : عبد عبادة ؛ ومنه لفظ الجلالة.
وفي البحار للمجلسيّ رحمه الله : «الله» إمّا مشتقّ من أله بمعنى عبد، أو من أله إذا تحيّر، أو من ألهت إلى فلان أي سكنت، أو من أله إذا فزع.
وفي المجمع : فعلى هذا يكون معناه : الّذي يحقّ له العبادة، ولذلك لا يسمّى به غيره.
ومنها : أنّه من «أله بالمكان» إذا قام به ووجود الخلق قائم بوجوده تعالى كقيام الظلّ بصاحبه على مذهب بعض.
ومنها : أنّه من «لاه» «يلوه» إذا ارتفع، لأنّ الله علا فاستعلى، وارتفعت صفاته عن صفة الخلوقين.
ومنها : أنّه من «ألهت إلى فلان» إذا فزعت ورجعت، وهو تعالى مرجع كلّ العباد في حوائجهم.
ومنها : أنّه من «ألهت بالمكان» إذا سكنت به، وينوّنون ويسكّنون بذكره
__________________
(١) الأنعام : ١٠٣.
(٢) الأعراف : ١٢٧.
تعالى «يا من اسمه دواء وذكره شفاء ».
ومنها : أنّه من «ألهت عليه» إذا قدرت على اختراعه وإبداعه، وهو الّذي ابتدع الخلق من غير وجود أحد يشاركه ويشاهده.
وبالجملة ؛ الأقوال في ذلك كثيرة ؛ لكنّ أصولها اثنان ؛ القول بأنّه مشتقّ من «أله» وأنّه من «لاه» والحقّ الأوّل، للحديث المذكور، وجميع المعاني الراجعة إليه صالح لإيقاعه عليه.
المخزن الثالث : في بيان مفهوم الجلالة، وفي أنّه علم أم مفهوم كلّيّ، وما يتعلّق بذلك
فنقول : قد اختلف العلماء في مفهوم الجلالة، فذهب جمّ غفير وجمع كثير إلى أنّها علم مفرد موضوع للذات الواجب وجوده، الجامع للصفات الإلهيّة المنعوت بالنعوت الربوبيّة، المنفرد بالوجود الأصليّ الحقيقيّ، واستدلّوا بوجوه كثيرة أقواها أنّه لو لم يكن علما لزم خروج كلمة «التهليل» وسورة «التوحيد» عن دلالة التوحيد.
وفيه كلام أنّه يحتمل كونها في الأصل مفهوما كلّيّا، فغلب إطلاقه عليه تعالى بحيث هجر المعنى الأوّل، فلا ينافي الدلالة المذكورة. فتأمّل.
وذهب بعض إلى أنّ مفهومها كلّيّ يطلق على كلّ من هو خالق للعالم، مستدلّا بأنّه لو كان علما يجب معرفة المسمّى للواضع، وهو غير ممكن.
وأجيب بوجوه أقواها : أنّ الواضع هو الله، وهو عالم بنفسه «فسبحان من لا يعلم كيف هو إلّا هو».
وهنا أبحاث كثيرة تنافي الموجز.
وقد خطر ببالي في سالف الأيّام، بل دوّنت في بعض كتبي أنّ الخلاف في مفهوم الجلالة وطول الكلام فيه غير مجد، لأنّ ذات الحقّ تعالى لا يعرفه أحد، ولا يحيطه وهم، ولا يحوم حول حماه فهم، فكيف يمكن أن يقال إنّه جزئيّ أم كلّيّ؟ لكنّ هذا الكلام في هذا المقام ليس بحسن ؛ إذ النزاع في مفهومها المفهوم الفهميّ الأوّليّ، وهو غير المفهوم التحقّقيّ المصداقيّ الثانويّ، فإنّ الإنسان مثلا له مفهوم وهو «الحيوان الناطق» ومصداق وهو «زيد» مثلا، فالاختلاف في كلّيّة الحيوان الناطق وجزئيّته لا يلزم الاختلاف في زيد.
الجنّة السادسة : في ما يتعلّق بالرحمن الرحيم
وفيها مرصدان.
المرصد الأوّل : في بعض خواصّهما
قال الكفعميّ : من خواصّهما حصول اللطف الإلهي إذا ذكرا عقيب كلّ فريضة مائة مرّة.
وقال غيره : من أراد الشفقة والمحبّة فليقل «يا رحيم» في كلّ يوم مائة مرّة.
ومن قاله في كلّ صباح تسعين مرّة يحبّه الخلائق.
ومن قال «يا رحمن» عقيب كلّ صلاة مائة مرّة يزيل النسيان والصعوبة عن قلبه.
ومن أقلقه مهمّ معجز فليقل «يا الله ويا رحمن ويا رحيم» عقيب صلاة العصر من يوم الجمعة إلى الغروب، ثمّ يسجد ويطلب حوائجه من قاضيها.
وخواصّهما الظاهريّة أكثر من أن تحصى.
وأمّا الباطنيّة فكثيرة أيضا :
منها : أنّه لو أخذ عددهما بالبسط التزبيريّ مع ملاحظة الواو العطفيّ من دون بسط يطابق عددهما مع عدد «هو إله حليم ساتر العيب أوّاب».
ومنها : أنّه لو أخذ عدد «يا رحمن» يطابق عدد «يا ربّ حسيب حيّا» وهو مطابق مع عدد «سيّد معبود عليّ» ؛ فلو بسط العبارة الأولى بالبسط التكسيريّ المقلوبيّ يظهر في بعض السطور «بحر سحاب» ليدلّ على أنّ قطرات سحاب رحمته كالبحر، وفي بعضها «حيّ برّ سابح» ليدلّ على أنّه القائم بنفسه، الراحم بعباده، السابح السائر في سفائن بحور رحمته، وفي بعضها «يا حبيب يا حاسر»، وفي بعضها «يا سحيب بارّ حيّ»، وفي بعضها «يا حيّ حريّ».
ومنها : أنّه لو بسط «الرحيم» بالتزبيريّ ثمّ بالبخسيّ ثمّ بالتخلّصيّ ثمّ بالأوّل يظهر من بعض السطور «كاف لأهل فدا» إشارة إلى أنّ الرحمة الرحيميّة خاصّة بالمؤمنين الّذين يشرون أنفسهم وأموالهم ابتغاء وجه الله، مضافا إلى قوله تعالى :( أَلَيْسَ اللهُ بِكافٍ عَبْدَهُ ) (١) .
ومنها : أنّ عدده مطابق مع «يا هو ويا سامع الدعاء».
ومنها : أنّ عدده موافق مع «يا هو جبّار مجيب».
ومنها : أنّه لو أخذ عدده الصغير يوافق عدد «جاد واحد ودود».
__________________
(١) الزمر : ٣٦.
المرصد الثاني : في كشف الحجاب عن معانيهما
فنقول : هما من الأوصاف المشبّهة، وفيهما معنى المبالغة، وهي في «الرحمن» أبلغ لكثرة مبانيه، وهي دالّة على كثرة المعاني على ما قاله الشيخ البهائيّ والقاضي البيضاويّ.
وبالجملة : هما مأخوذان من الرحم، ومنه يؤخذ الرّحم لمنبت الولد.
قال الكفعميّ في «المصباح» : الرحمة لغة رقّة القلب وانعطاف يقتضي التفضّل والإحسان، ومنه الرّحم لانعطافها على ما فيها.
ونقل عن المرتضى رحمه الله أنّه قال : ليست الرحمة عبارة عن رقّة القلب والشفقة، إنّما هي عبارة عن الفضل والإحسان والإنعام.
قال : فعلى هذا يكون إطلاق لفظ الرحمة عليه تعالى حقيقة، وعلى الأوّل مجازا.
ونقل عن أحمد بن فهد رحمه الله أنّه قال : إنّ رقيق القلب من الخلق يقال له رحيم، لكثرة وجود الرحمة منه بسبب الرقّة، وأقلّها الدعاء للمرحوم والتوجّع له، وليست في حقّه تعالى كذلك، بل معناها إيجاد النعمة للمرحوم وكشف البلوى عنه(١) .
أقول : الرحمة لها معان كثيرة على الاشتراك ؛ تختلف باختلاف المواضع :
فمنها : «النعمة» كما قال :( وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ ) (٢) .
__________________
(١) مصباح الكفعميّ : ٣١٧.
(٢) الأنبياء : ١٠٧.
ومنها : «الرزق» كما قال :( ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ ) (١) .
ومنها : «النفع» كما قال :( وَإِذا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ ) (٢) .
ومنها : رقّة القلب، كما قال : «لن يرحموكم».
وبالجملة ؛ إطلاق الرحمة على «الله» بالمعاني الاول شائع، وبالمعنى الأخير غير ذائع، فالقول بأنّ إطلاق «الرحمن» على «الله» تعالى مجاز بلا حقيقة بعيد، والاشتراك يدفعه، فتأمّل.
فلذا قيل : هي ـ أي «الرحمة» ـ إذا استعملت في «الله» عبارة عن برّه وإحسانه، وفي العباد عبارة عن رقّة القلب.
فظهر أنّ إطلاق «الرحمة» على الحقّ ليس مجازا، لكن «الرحمن» اسم خاصّ به تعالى لا يطلق على غيره، لأنّه قائم مقام «الله» لقوله :( ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ ) (٣) فلذا قيل : «الرحمن» علم لا صفة. و «الرحيم» غير خاصّ به، لإطلاقه عليه وعلى غيره.
وبينهما فرق آخر وهو أنّ «الرحمة» الرحمانيّة عامّة وسعت كلّ شيء، وهي على ما قاله الطبرسيّ إنشاؤه إيّاه وخلقهم وإعطاء الوجود به و «الرحمة» الرحيميّة خاصّة بالمؤمنين، فلذا قال :( وَكانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً ) (٤) وهذا معنى ما روي من أنّ «الرحمن» اسم خاصّ بصفة عامّة
__________________
(١) الإسراء : ٢٨.
(٢) يونس : ٢١.
(٣) الإسراء : ١١٠.
(٤) الأحزاب : ٤٣.
«والرحيم» اسم عامّ بصفة خاصّة(١) .
وفي المجمع عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : إنّ لله عزّ وجلّ مائة رحمة، وإنّه أنزل منها واحدة إلى الأرض فقسّمها بين خلقه ؛ بها يتعاطفون ويتراحمون، وأذخر تسعا وتسعين لنفسه يرحم بها عباده يوم القيامة(٢) .
وفيه أيضا : إنّ الله قابض هذه إلى تلك فيكملها مائة يرحم بها عباده يوم القيامة.
والأخبار في وفور رحمته الرحيميّة لعباده ؛ سيّما لامّة محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم في الدنيا والآخرة كثيرة متواترة.
فائدتان :
الاولى : قال العلّامة الطبرسيّ في مجمع البيان : إنّما قدّم «الرحمن» على «الرحيم» لأنّ «الرحمن» بمنزلة الاسم العلم بحيث لا يوصف به إلّا الله.
أقول : وتقديم «الرحمن» على «الرحيم» إنّما هو لعموم فيه، وفي قوله : «سبقت رحمته غضبه » دلالة عليه ؛ إذا الرحمة الرحيميّة للمؤمنين عذاب وغضب للكافرين، وما قيل من أنّ الرحمة الرحمانيّة إنّما هي في الدنيا والرحيميّة في الاخرى، فلذا قدّم «الرحمن» على «الرحيم» لتقدّم الاولى على الثانية ليس بوجيه، لما قاله الطبرسيّ من أنّ وجه خصوص «الرحيم» بالمؤمنين هو ما فعله بهم في الدنيا من التوفيق، وفي الآخرة من الجنّة
__________________
(١) مصباح الكفعميّ : ٣١٧، المقام الأسنى : ٢٩.
(٢) الصراط المستقيم ٣ : ٦٩، الطرائف ٢ : ٣٢٢، نهج الحقّ : ٣٧٤.
والإكرام وغفران الذنوب والآثام.
فظهر من كلامه رحمه الله أنّ الرحمة الرحيميّة ليست خاصّة بالآخرة، إلّا أن يقال إنّ ما يصدف المؤمن في الدنيا من النعم المتواترة هو بالرحمة الرحمانيّة، وإلّا يلزم تخصيص تلك الرحمة بالكفّار، وهو بعيد.
الثانية : نقل الكفعميّ في «المصباح» و «الرسالة الواضحة» عن السيّد المرتضى رحمه الله أنّ «الرحمن» يشترك فيه اللغة العربيّة والعبرانيّة والسريانيّة، و «الرحيم» مختصّ بالعربيّة(١) .
أقول : ولفظ الجلالة أيضا يشترك فيه العربيّة والسريانيّة، وقال بعض : هو سريانيّ معرّب.
قال الطبرسيّ رحمه الله : وما حكي عن تغلب أنّ لفظة «الرحمن» ليست بعربيّة، وإنّما هي ببعض اللغات مستدلّا بقوله تعالى :( وَمَا الرَّحْمنُ ) (٢) إنكارا منهم لهذا الاسم، فليس بصحيح، لأنّ هذه اللفظة مشهورة عند العرب، موجودة في أشعارها.
أقول : وجه عدم الصحّة إنّما هو نفي المسمّى وإنكاره لا الاسم. فليتأمّل.
خاتمة :
قالت الصوفيّة: العبد مكلّف بالتخلّق بمقتضى مفهوم اسمه، لأنّ الأسماء تنزل من السماء، فمن كان اسمه «عبد الله» ينبغي عليه أن يتخلّق بجميع الصفات الكماليّة حتّى يتجلّى الله فيه بجميع أسمائه وصفاته. قال
__________________
(١) مصباح الكفعميّ : ٣١٧.
(٢) الفرقان : ٦٠.
صلّى الله عليه وآله وسلّم : خير الأسماء «عبد الله» و «عبد الرحمن»(١) . وقال الله تعالى :( لَمَّا قامَ عَبْدُ اللهِ ) (٢) ويؤيّده :( وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللهَ رَمى ) (٣) .
مظهر اسم أعظم است آن شاه |
بحقيقت يكى است عبد الله |
ومن كان اسمه «عبد الرحمن» ينبغي عليه أن يتخلّق بالرحمة الواسعة، ومن كان اسمه «عبد الرحيم» ينبغي أن يتخلّق بالرحمة الرحيميّة.
دوستان را به لطف بنوازد |
دشمنان را به قهر بگدازد |
وعلى ذلك قس سائر الأسماء.
وهنا تفاصيل ذكرت في المفصّلات، والحمد لله حقّ حمده.
__________________
(١) الخصال ١ : ٢٥٠.
(٢) الجنّ : ١٩.
(٣) الأنفال : ١٧.
الفصل الثاني
في بعض ما يتعلّق بقوله تعالى( الْحَمْدُ لِلَّهِ )
وفيه مقامات.
المقام الأوّل : في إعرابه وما يتعلّق به
فنقول : كان «الحمد» في الأصل مصدرا لفعل يجانسه فزحف العامل وبقي معموله مرفوعا بالعامل المعنويّ وهو الابتدائيّة ؛ كما هو اللغة المشهورة، بل ادّعى الطبرسيّ على ذلك إجماع القرّاء، أو منصوبا على المصدريّة للمحذوف كما نقل عن الشواذّ، والمختار الأوّل، لإفادة العموم في «الحمد» لجميع الخلق، بخلاف الثاني لما فيه من تخصيصه بالمتكلّم فقط ؛ قاله الطبرسيّ أيضا.
وفيه نظر، لأنّ لزوم التخصيص مختصّ بما لو قدّر «أحمد الحمد» على صيغة التكلّميّ الفرديّ، وأمّا لو قدّر «نحمد» فلا يضرّ العموم، وتخصيص الأوّل بالتقدير كما صنعه رحمه الله تخصيص بلا مخصّص وهو قبيح، فالأحسن أن يقال : ترجيح الرفع فيه إنّما هو إنساء الفعل المحذوف، فكأنّه لم يحذف، بل «الحمد» مبتدأ، فعدم ارتكاب الحذف أولى لمجازيّة الحذف،
بل أقول : القول بالحذف هنا منويّا ومنسيّا غير حسن، لأنّ الفعل دالّ على التجدّد والحدوث، وكون «الحقّ» محمودا في زمان دون آخر غير مرضيّ، بل كان محمودا في أزل الآزال وهو الكبير المتعال.
وما قاله الحكيم أيضا في حواشي «البهجة» عند خطبة الجلال السيوطيّ وهي «أحمدك اللّهمّ على نعمك وآلائك ...» : فلمّا كان هذا الكتاب من النعم المتجدّدة ناسب أن يؤتى فيه بما يدلّ على الجدّيّة، هذا بخلاف «كتاب الله» العزيز، فإنّه قديم لم يحدث ولم يتجدّد، فالاسميّة به أنسب، غلط في مذهبنا الإماميّة، لأنّ القرآن عندنا حادث، ليس بقديم، للأدلّة والبراهين الّتي ذكرناها في علم الكلام، وهنا أبحاث كثيرة لا يسعها المقام.
ولو قلنا أنّ القول بالحذف وجعل «الحمد» مبتدأ أحسن، لما فيه من الدلالة على أنّ حمده تعالى مصاحب لجميع الأزمنة ؛ محقّقة كانت أم مقدّرة، سواء كان في الأزل أم في الحدوث، يعني : أنّه كان محمودا حيث ما كان حامد وحيث كان، لكان حسنا لكنّه غير محتاج إليه.
ونقل عن بعض كسر «الدال» ولا وجه له إلّا الاتّباع والمجاورة للام من الجلالة إن قلنا بجواز ذلك مطلقا، وأمّا لو منعناه مطلقا أو قلنا بجواز الاتّباع للثاني في حركة الأوّل خاصّة لتبادر اتّباع هذا دون العكس، فلا، وكذا لو منعنا اتّباع المعرّب للمبنيّ للاختلاف بين حركتهما أو قلنا بتخصيص الاتّباع مع الضعف في كلمة واحدة ؛ كما قاله الطبرسيّ رحمه الله.
ونقل عن ابن جنّي أنّه قال : في كسر «الدال» وضمّ «اللام» هنا دلالة شديدة على شدّة ارتباط المبتدأ بالخبر، لأنّه اتّبع فيهما ما في أحد الجزءين
ما في الجزء الآخر، وجعل بمنزلة الكلمة الواحدة.
وبالجملة ؛ وعلى كلّ التقادير الأظهر أنّ «اللام» فيه للجنس وهو مطلق الحقيقة أي حقيقة الحمد وجنسه لله. ويؤيّده عدم جواز الاستثناء فيقال : الحمد لله إلّا حمد فلان ؛ إذ هو محمود كلّ حامد، وحمد دونه حمد له.
وفي الكافي : عن عليّ بن الحسين عليهما السلام أنّه قال : يقول الله لعبد من عبيده يوم القيامة : أشكرت فلانا. فيقول : بل شكرتك يا ربّ. فيقول : لم تشكرني إذ لم تشكره، ثمّ قال عليه السلام : أشكركم لله أشكركم للناس(١) إلى آخره.
وقيل : «اللام» للاستغراق، ويظهر من بعض كلمات أصحابنا عدم الفرق بينه وبين الجنس، لكن الفرق هو أنّ الجنس طبيعة واحدة، فلا يجوز الاستثناء دون الاستغراق، فيجوز عنه الاستثناء ؛ كما في قوله :( إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ) (٢) الآية.
وقيل : «اللام» للعهد، قال المقداد على ما نقل عنه الكفعميّ : ليست بعهديّة، لعدم تقدّم معهود، وفيه نظر، لأنّ المراد «بالحمد» هو الحمد المعهود عند الله اللائق بجلاله.
قال إبراهيم الكفعميّ في «الرسالة الواضحة» : قد يمكن أن يكون في كلام عليّ عليه السلام : لو شئت أن أوقر بعيرا من قوله «الحمد لله» لفعلت. فإنّ الحمد هو الثناء، والثناء يكون بإثبات الكمال تارة وسلب النقص
__________________
(١) الكافي ٢ : ٩٩.
(٢) العصر : ٢ ـ ٣.
اخرى، وتارة الاعتراف بالعجز إدراكه، وتارة بإثبات الكمال والتفرّد، دلالة على أنّ «اللام» في «الحمد» للجنس.
أقول : هذا الأثر لا يمحّض «اللام» للجنسيّة، لأنّ ذلك يشمل الاستغراق الحقيقيّ أيضا، فلا دلالة. فليتأمّل.
وأمّا قوله تعالى( لِلَّهِ ) فظرف متعلّق بالفعل المحذوف وهو «حقّ» أو «استقرّ» أو «خصّ» أو نحو ذلك ممّا يناسب المقام على ما اختاره الطبرسيّ، لأنّ الأصل في الجمل، الفعليّة، فتقدير الفعل أولى.
وقيل : الاسم مقدّر وهو «مستقرّ» أو «خاصّ» أو نحوهما.
ويؤيّده أيضا : ما أسلفناه من أنّ حمده تعالى غير متجدّد، بل هو قديم، فهو المحمود في أزل الآزال والمتفرّد بالجمال والكمال، فعدم تقدير الفعل الموضوع للحدث أولى. لكنّ الأقوى عندي جواز الوجهين عند عدم وقوع الحذر في كلّ مواضع، والفعل بعد الموصول، والاسم بعد إمّا وإذ المفاجاتيّة، وهذا التفصيل مختارنا في «المصابيح».
فائدة :
نقل الطبرسيّ رحمه الله عن الشواذّ ضمّ «اللام» من «لله» تبعا «للدال» وفتح الدال وكسر اللام، ونقل عن سيبويه أنّ الأصل في هذه «اللام» الفتح، لأنّ الحرف الواحد لا حظّ له في الإعراب، ولكنّه يقع في أوّل الكلمة ولا يبتدئ بساكن، فاختير له الفتح، لأنّه أخفّ الحركات، إلّا أنّهم كسروها لأنّهم أرادوا أن يفرّقوا بين لام الملك ولام التوكيد، إذا قلت المال لهذا أي في ملكه، وأنّ المال لهذا أي هو هو، وإذا أدخلوا هذه «اللام» على مضمر ردّوها
إلى أصلها وهو الفتح، لأنّ اللّبس قد ارتفع، وذلك لأنّ ضمير الجرّ مخالف لضمير الرفع.
فائدة أخرى :
قد عنونوا في الكتب النحويّة أنّ للام الجارّة معاني كثيرة :
أوّلها : «الاستحقاق» وهو يتحقّق إذا وقعت «اللام» بين الوصف والذات ؛ كما في «الحمد لله» و «العزّة لله»، وفي حكمه الاختصاص ؛ كما في قوله : «الجنّة للمؤمنين» والملك ؛ كما في قوله :( لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ) (١) ويشابه الملك التمليك، كقولك «وهبت لك هذا» والفرق بينهما هو الفرق بين الفعل والانفعال. فتدبّر.
قيل : «اللام» في قوله :( جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً ) (٢) شبه التمليك.
وثانيها : «التعليل» ويسمّى بالعلّة والسبب ومن أجله أيضا ؛ كما في قوله :( إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ ) (٣) واللام في قوله :( لِإِيلافِ قُرَيْشٍ ) (٤) تعليليّة متعلّقة بقوله :( فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَيْتِ ) والقول بأنّها متعلّقة بقوله :( فَجَعَلَهُمْ ) نظرا إلى أنّ السورتين في مصحف أبيّ سورة واحدة منقول عن بعض، وعن آخر تعلّقها بمحذوف وهو «أعجبوا».
وثالثها : «القسم» كما في قوله :( لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ) (٥) .
__________________
(١) آل عمران : ١٨٩، المائدة : ١٧ و ١٨ و ١٢٠، النور: ٤٢،الشورى : ٤٩، الجاثية : ٢٧، الفتح : ١٤.
(٢) الشورى : ١١.
(٣) الإنسان : ٩.
(٤) قريش : ١.
(٥) الحجر : ٧٢.
ورابعها : «الصيرورة» وهي لام العاقبة ؛ كما في قوله :( لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا ) (١) إلى آخره.
وخامسها : «الغرض» كما في قوله( وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ) (٢) ذكره بعض كالكفعميّ، وهو كالتعليل ظاهرا.
وبالجملة ؛ أقسام اللامات كثيرة لا يليق ذكرها [بهذا] الموجز.
خاتمة :
قال القرّاء : وصل الميم من «البسملة» باللام من «الحمد» مستحبّ، ويرقّق اللام من( لِلَّهِ ) إذا قدمته الكسرة، ويفخّم إذا سبقته الفتحة أو الضمّة.
قال الطبرسيّ رحمه الله : إنّما تغلّظ لام «الله» إذا تقدّمته الضمّة أو الفتحة تفخيما لذكره، وإجلالا لقدره، وليكون فرقا بينه وبين ذكر اللات.
أقول : الترقيق والتفخيم معمولان في اللام أيضا، وهما غير واجبين عند الفقهاء، والظاهر أنّ القرّاء يوجبونهما. فليتأمّل.
المقام الثاني : في فضيلة الحمد لله والشكر له، وكيفيّة ذلك
على ما يظهر من الأخبار
فنقول : إنّ الله عزّ وجلّ قد حمد نفسه في مواضع كثيرة، ومواقع غير محصيّة، فيجب علينا شكره وحمده ؛ إذ هو المنعم الحقيقيّ، وهو الّذي أسبغ علينا من نعمه المتظاهرة، وآلائه المتواترة، ومننه المتعاقبة، ووجوب
__________________
(١) القصص : ٨.
(٢) الذاريات : ٥٦.
شكر المنعم ممّا حكم به العقل الكامل، ولا يخفى أنّ فائدة الحمد ليست عائدة إليه تعالى، بل إلى العبد ؛ إذ به يزيد الله نعمه عليه، فلذا قال :( لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ ) (١) فلك الحمد يا من له في كلّ نفس من الأنفاس، وخطرة من الخطرات منّا منه منن لا تحصى، وفي كلّ لحظة من اللحظات نعم لا تنسى، وفي كلّ حال من الحالات عائدة لا تخفى.
وفي الكافي : عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : ما فتح الله على عبد باب شكر فخزن عنه باب الزيادة(٢) .
أقول : ويؤيّده قوله تعالى :( لَأَزِيدَنَّكُمْ ) ويعضده أيضا : ما فيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أعطي الشكر أعطي الزيادة.
وفيه عنه عليه السلام : ما أنعم الله على عبد من نعمة فعرفها بقلبه وحمد الله ظاهرا بلسانه فتمّ كلامه حتّى يؤمر له بالمزيد(٣) .
أقول : قوله «فعرفها» إلى آخره، مخفّفا أي علم وعقد بقلبه أنّها من عند الله ويسمّى ذلك بالحمد الباطنيّ الجنانيّ.
قوله «وحمد الله ظاهرا» إلى آخره، إشارة إلى الحمد اللّسانيّ الّذي يظهر باللسان بقوله مثلا «الحمد لله» ونحوه. ولعلّ ذلك معنى قوله تعالى :( وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ) (٤) أي : أظهرها بلسانك موافقا لما عقدت عليه.
قوله «حتّى يؤمر» إلى آخره، متعلّق بقوله «ما أنعم الله» إلى آخره.
__________________
(١) إبراهيم : ٧.
(٢) الكافي ٢ : ٩٥.
(٣) الكافي ٢ : ٩٥.
(٤) الضحى : ٤.
وفيه أيضا : عنه عليه السلام قال : شكر النعمة اجتناب المحارم، وتمام الشكر قول الرجل : الحمد لله ربّ العالمين(١) .
أقول : وقوله «تمام الشكر» أي ما يتمّ به بحيث لو فقد لنقص كنقصان البدن بلا رأس، وهذا معنى ما روي بأنّ «الحمد رأس الشكر»(٢) .
وفيه : عنه عليه السلام : شكر كلّ نعمة عظمت أن تحمد الله(٣) .
وفيه : عن أبي بصير قال : قلت له عليه السلام : هل للشكر حدّ إذا فعله كان شاكرا؟ قال : نعم. قلت : ما هو؟ قال : يحمد الله على كلّ نعمة عليه في أهل ومال(٤) .
وفيه : عنه عليه السلام : ما أنعم الله على عبد بنعمة صغرت أو كبرت فقال : الحمد لله إلّا أدّى شكرها(٥) .
وفيه أيضا : عنه عليه السلام قال : ما أنعم الله عليه بنعمة فعرفها بقلبه إلّا أدّى شكرها(٦) .
أقول : فيه إشارة إلى الشكر الباطنيّ، وهو المراد بأداء الشكر، لكنّه ناقص أيضا إلّا مع ضميمة الحمد باللسان، وكذا الظاهري ناقص إلّا بضميمة الباطنيّ.
__________________
(١) الكافي ٢ : ٩٥.
(٢) مجموعة ورّام ٢ : ١٠٦.
(٣) الكافي ٢ : ٩٥، الخصال ١ : ٢١.
(٤) الكافي ٢ : ٩٥.
(٥) الكافي ٢ : ٩٦.
(٦) الكافي ٢ : ٩٦.
وفيه : عن حمّاد بن عثمان قال : خرج أبو عبد الله عليه السلام من المسجد وقد ضاعت دابّته، فقال : لئن ردّها الله عليّ لأشكرنّ الله حقّ شكره. قال : فما لبث أن اتي بها، فقال : الحمد لله. فقال قائل له : جعلت فداك، أليس قلت لأشكرنّ حقّ شكره؟ فقال : ألم تسمعني قلت : الحمد لله(١) .
أقول : قد يظنّ البادئ بذلك الحديث اتّحاد الحمد والشكر، وليس كذلك، لأنّ ذلك من مواضع الاجتماع، وسيجيء التفصيل.
المقام الثالث : في التفرقة بين الحمد والشكر والمدح على طريق الإجمال
فنقول : الحمد اللغويّ هو الثناء بالجميل الاختياريّ على قصد التبجيل مطلقا، والمراد بالحمد الاختياريّ الأفعال الحسنة الّتي تنشأ من المحمود على طريق اختياره، أي بحيث لو أراد تركها لقدر، كذا قيل. وفيه نظر، لعدم شمول ذلك المحامد الربّانيّة الّتي بها يحمد صفاته الذاتيّة هي عين الذات، لأنّه قد حقّق في مقامه أنّ تلك الصفات لا يمكن نفيها عنه تعالى ؛ إذ في نفيها يلزم نفي الذات، فصفاته تعالى موجبة ؛ قاله بعض.
أقول : وفيه أنّه إذا ثبت كون الصفات عين الذات، فالجميع ذات واحدة على سبيل التحقّق، فيصدق أن يقال : العلم هو الله مثلا، فالقول بإيجاب الصفات مستلزم لإيجاب الذات، وقد حقّقنا في علم الكلام خلافه، فلذا قيل : إنّ الاختياريّ معناه المنسوب إلى الفاعل المختار، فالمراد بالجميل الاختياريّ الفعل الحسن الّذي كان فاعله مختارا، وبذلك يدفع ما قيل من أنّ
__________________
(١) الكافي ٢ : ٩٧.
التعريف مخدوش ؛ إذ الحمد على حسن زيد وشجاعته مثلا خارج منه ؛ إذ هما من الصفات اللازمة، لأنّ المراد بالجميل الاختياريّ ما كان صاحبه مختارا، وزيد فاعل مختار في سائر أفعاله.
ويمكن أن يقال إنّ الاختياريّ ليس وصفا للجميل، بل هو للثناء، ومن ذلك يخرج حمد المكره في حمده. فليتأمّل.
والحمد الصناعيّ هو الشكر اللغويّ المعبّر عن فعل يلوح عن تعظيم المنعم لنعمته مطلقا، وهو الحمد المذكور في الأخبار السابقة.
والمراد بالنعمة : الأفعال الحسنة المتعدّية بالغير ؛ فالشجاعة ليست بنعمة لغير الشجاع، وأمّا له فنعمة، لأنّها من جانب الله، وكذا الوجود ونحوه ممّا أعطانا الله.
وأمّا الشكر الصناعيّ ؛ عبارة عن صرف العبد جميع ما أنعمه الله في بدنه، وفي ماله في موضعه ؛ فاللسان للذكر والأقوال الحسنة، والعين للنظر إلى الصنائع وحفظها من النظر إلى المحارم، والقلب لله فكذلك، والمال للإنفاق، وغير ذلك، فلذا ورد من «أنّ شكر النعمة اجتناب المحارم ...» إلى آخره.
والمدح هو القول المنبئ عن عظم حال الممدوح مع القصد إليه ؛ قاله الطبرسيّ.
ولا يشترط كون الممدوح مختارا عاقلا، فلذا قيل : الحمد لا يكون إلّا لمن يعقل، والمدح يكون له ولغيره.
ونقل عن المقداد أنّه قال : الحمد صفات الكمال الاختياريّ، والمدح ذكر الكمال مطلقا. انتهى.
ويؤيّد عدم الشرطيّة، قولهم : مدحت اللؤلؤ لصفاتها، ومدحت الفرس لسرعة مشيه، لكن كثيرا ما يستعمل في العاقل المختار.
ومنه :
كريم متى أمدحه أمدحه والورى |
معي وإذا ما لمته لمته وحدي |
ومنه يظهر تقابل المدح مع اللوم، لكنّه ليس بوجيه ؛ إذ هو مقابل الهجاء.
قال الكفعميّ : الحمد والمدح إخوان ؛ لأنّ الحمد مقلوب المدح.
أقول : ذلك بالبسط التكسيريّ بالصدر المؤخّر.
وبالجملة ؛ قد ظهر ممّا سبق أنّ بين الشكر اللغويّ والحمد الصناعيّ ترادف، وبين الحمد والمدح عموم مطلق ؛ إذ كلّ حمد مدح لا بالعكس. وقد علمت، وبين الحمد اللغويّ والشكر الصناعيّ عموم من وجه، لإفراد الحمد في قوله تعالى :( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً ) (١) لعدم سبق نعمة، وإفراد الشكر في قوله :( اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكْراً ) (٢) إذ المتبادر من العمل، العمل بالجوارح كالصلاة ونحوها، واجتماعهما في قوله :( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْماعِيلَ ) (٣) انتهى.
فائدة :
قد خطر ببالي انتفاء الحمد الصناعيّ في كلّ ما نسب إلى الله ؛ لأنّ لفظة
__________________
(١) الإسراء : ١١١.
(٢) سبأ : ١٣.
(٣) إبراهيم : ٣٩.
«الله» قد وضع للذات الجامع لجميع الصفات الكماليّة، فلا يخلو من معنى الوصفيّة، وقد حقّق في مقامه أنّ تعليق الحكم بالوصف مشعر بعلّيّة المأخذ له، يعني : علّة وجود الحكم، هو الوصف العارض للمحكوم عليه.
فإذا قيل : أكرم العبّاد لا غيرهم، يفهم أنّ علّة الإكرام هي العبادة واتّصافهم بها، وقولك : «الحمد لله» أي الحمد خاصّ له لا يستحقّه غيره، لأنّه هو المستجمع للصفات، فعلّة الحمد هي الاستجماع المذكور. ويؤيّده قولهم هذا كدعوى الشرّ بالبيّنة والبرهان، فعلى هذا لا يمكن أن يقال : الحمد صناعيّ ؛ إذ الصناعيّ على ما قلتم حمد كان علّته النعمة، وقد حقّقنا أنّ العلّة غيرها، وحينئذ يلزم استعمال المشترك في معنييه على فرض الاجتماع. فليتأمّل.
خاتمة :
قد علمت أنّ الحقّ تعالى هو المنعم فيجب شكره وحمده، ولا يخفى أنّ الشكر لا يتحقّق ولا يؤدّي إلّا بمعرفة المشكور ليشكر بما يناسب حاله، فشكر الحقّ غير ممكن إلّا بمعرفته، فهي واجبة على كلّ مكلّف، وطريقها إثبات وجوده تعالى أوّلا بالعقل، ثمّ توحيده تعالى بأقسامه ثانيا، ثمّ صفات الكمال والجمال والجلال له ثالثا، ولجميع ذلك تفاصيل مذكورة في المفصّلات، وسيجيء بعضها إن شاء الله عن قريب، والحمد لله.
الفصل الثالث
في تفسير قوله تعالى( رَبِّ الْعالَمِينَ * الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ )
وفيه مراصد وخاتمة.
المرصد الأوّل : في إعرابه
فنقول : القراءة المشهورة المعمولة بها جرّ «الربّ» ليكون بدلا لقوله «لله» بدل المطابق، ويحتمل كونه صفة له، واختاره الطبرسيّ أيضا، وفيه نظر ؛ إذ المطابقة المعتبرة بين الموصوف والوصف مفقودة هنا، لتعريف الأوّل دون الثاني، لأنّ «الربّ» صفة مشبّهة، وإضافتها لفظيّة، وهي لا تكتسب التعريف.
والقول بأنّ معنى «الربّ» ماض، فالإضافة معنويّة ؛ كقوله( فاطِرِ السَّماواتِ ) (١) إلى آخره، مخدوش للزوم ذلك عدم كونه تعالى ربّا ومربّيا للعالم في الحال والاستقبال، بل الربّ من صفات الذات إن عني به السيّد، ولو عني به المدبّر لخلقه فمن صفات الفعل، فلا يصحّ أيضا نفي تدبيره في سوى الماضي، إلّا أن يراد من التدبير : التدبير التقديريّ لا التكوينيّ. فليتأمّل.
__________________
(١) الأنعام : ١٤.
ويمكن أن يجاب ـ بل هو المتعيّن ـ بأنّ أسماء الله تعالى معارف كلّها في نفسها لا بواسطة، ألا ترى أنّه قال الطبرسيّ «اللام» في الجلالة مزيدة للتفخيم والتعظيم، ومن زعم أنّها للتعريف فقد أخطأ ؛ لأنّ أسماء الله تعالى معارف. انتهى.
فعلى هذا لا ضير في كون «الربّ» مجرورا لكونه نعتا للربّ، وممّا يؤيّد تعريفه عدم استعماله في غيره تعالى بدون الإضافة، بل هو ممّا يخصّ به تعالى عند إضافته «للعالمين».
وممّا يؤيّد النعتيّة : ما روي عن زيد بن عليّ عليه السلام أنّه قرأ رب العالمين بفتح «الباء» نظرا إلى قطع الوصفيّة ونصبه للمدح مفعولا، ولا يجوز القطع في غير الوصف، بل هو ممّا يقطع وينصب على المفعوليّة إن لم يكن منصوبا، ويرفع على تقدير المبتدأ إن كان منصوبا أو مجرورا.
قال الطبرسيّ : ومن نصب رب العالمين فإنّما ينصب على المدح والثناء، كأنّه لمـــّـا قال( الْحَمْدُ لِلَّهِ ) استدلّ بهذا اللفظ على أنّه ذاكر لله، فكأنّه قال : أذكر ربّ العالمين، فعلى هذا لو قرأ في غير القرآن «ربّ العالمين» مرفوعا على المدح أيضا لكان جائزا على معنى هو ربّ العالمين. انتهى.
وبالجملة ؛ لا ينبغي أن يقرأ «الربّ» إلّا مجرورا سواء كان بدلا أم صفة.
واختلف في العامل فيه، بل في كلّ تابع ؛ فقيل : العامل هو العامل في المتبوع، ونسبه الأزهريّ إلى الجمهور، ونقل نسبته إلى سيبويه عن بعض، وذلك غير مطّرد لتخالفه في نحو «يا زيد العالم» إذ يلزم دخول الياء على المحلّى باللام، وهو ممنوع إلّا فيما استثني، إلّا أن يقال بقاعدة الاغتفار المعروف فلا ضير، وحذف العامل في البدل خاصّة، قول نادر بل ضعيف
لمخالفته للأصل، والأشبه كما ذهب إليه الخليل وغيره أنّ العامل هو التبعيد، وهي معنويّ كالابتدائيّة في المبتدأ.
وأمّا( الْعالَمِينَ ) فمجرور بالإضافة أو بالمضاف على الاختلاف.
و( الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) مجروران على كونهما صفتين بعد الصفة.
ولا يخفى أنّه قد اختلف في أنّه إذا تعدّدت الأوصاف، فهل الأخير وصف لسابقه المتلوّ أم للأسبق المتقدّم على الكلّ؟ وهو الأظهر، واللام فيهما ليست للتعريف، بل للتفخيم ؛ كما مرّ.
المرصد الثاني : في معنى «الربّ» وما يتعلّق به
فنقول : وقد يظهر من كتب اللغات والتفاسير أنّ للربّ معان كثيرة :
منها : وهو الأظهر أنّه من «التربية» و «التدبير»، فالحقّ ربّ أي مربّ للخلائق ومدبّرها ومصلحها ومصيّرها بحدّ الكمال تدريجا، وسيجيء بعض كيفيّات التربية عن قريب في حقّ بعضها.
ومنها : وهو القريب من الأوّل أنّه بمعنى «الخالق».
ومنها : وهو قريب أيضا أنّه بمعنى «المصلح للأمور».
ومنها : وهو قريب أيضا أنّه بمعنى «المحوّل للأوضاع والأحوال».
ومنها : وهو قريب أيضا أنّه بمعنى «الثابت».
ومنها : أنّه بمعنى «الدائم لطفه».
ومنها : أنّه بمعنى «السيّد المطاع» كما قال :( أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً ) (١) .
__________________
(١) يوسف : ٤١.
ومنها : أنّه بمعنى «المالك» كما قال صلّى الله عليه وآله وسلّم : أربّ غنم أنت أم ربّ إبل(١) .
قال الطبرسيّ والكفعميّ : لا يطلق «الربّ» على غير «الله» إلّا مقيّدا فيقال : ربّ الدار، وربّ البيت.
خاتمة :
قيل : الربّ من أسماء الأعظم ؛ إذ به أسند استجابة الدعوات في القرآن في مواضع كثيرة ؛ كما قال :( ادْعُوا رَبَّكُمْ ) (٢) ( فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ ) (٣) إلى آخره.
وخواصّه كثيرة :
منها : حفظ الأولاد ؛ إذا أدمن على ذكره.
منها : قضاء الحاجات والمطالب.
المرصد الثالث : في ذكر بعض كيفيّات تربيته تعالى لبعض الخلائق
فنقول : إنّه قد علمت أنّ الأظهر من معاني «الربّ» ما أخذ من التربية وهي على ما قاله البهائيّ رحمه الله والكفعميّ رحمه الله : تبليغ الشيء كماله شيئا فشيئا، أي على سبيل التدريج، ولا يخفى أنّ لله تعالى خلقا كثيرا لا يمكن عدّها وإحصاؤها، ولكلّ منها تربيته خاصّة من جانب الله، وفي الكلّ
__________________
(١) مصباح الكفعميّ : ٣٣٥.
(٢) الأعراف : ٥٥.
(٣) آل عمران : ١٩٥.
تدبيرات لا يعلم أكثرها العارفون ولا يطّلع عليها الحكماء والعالمون، وما أتى الله علمها إلّا قليلا من عباده الصالحين، وليس في طاقة البشر إحصاء كيفيّات التدبير في جميع الخلق إلّا القليل منها كالإنسان مثلا، فلو نظر العاقل فيه بعين البصيرة لرأى فيه تدبيرات عجزت عن دركها أفهام السالكين وأوهام المجتهدين، مع أنّه كان في الأوّل من سلالة من طين، ثمّ صار نطفة، ثمّ علقة ـ وهي القطعة الجامدة من الدم ـ ثمّ مضغة بعد أربعين يوما، فكساها عظاما، فكسى العظام لحما، وجعل له أعضاء شريفة ظاهرة وباطنة، كان محتاجا إليها كالعين ليرى ويفرّق السهل من الجبل، والبئر من القفر، والسمع ليدرك بها الأصوات ويميّز خفيّها عن جليّها، وحسنها من كريهها، والدماغ ليدرك بقوّته الرياح الطيّبة والخبيثة، والذائقة ليدرك بها المرّ والحلو والحامض، واللامسة ليدرك بها البرودة والحرارة، والمتخيّلة ليتخيّل ويتفكّر بها، وكذلك سائر الأعضاء والجوارح الّتي تشاهدها والّتي لا تشاهدها، وفي كلّ منها لحكم كثيرة لا نعلمه ولا يعلمه إلّا هو.
وفي «توحيد المفضّل رحمه الله» : يا مفضّل، إنّ الشكّاك جهلوا الأسباب والمعاني في الخلقة، وقصرت أفهامهم عن تأمّل الصواب والحكمة فيما ذرأ الباري وبرأ من صنوف خلقه في البرّ والبحر، والسهل والوعر، فخرجوا بقصر علومهم إلى الجحود، وبضعف بصائرهم إلى التكذيب والعنود، حتّى أنكروا خلق الأشياء، وادّعوا أنّ كونها بالإهمال لا صنعة فيها ولا تقدير، ولا حكمة من مدبّر ولا صانع، تعالى الله عمّا يصفون، وقاتلهم الله أنّى يؤفكون، فهم في ضلالهم وعميهم وتحيّرهم بمنزلة عميان
دخلوا دارا قد بنيت أتقن بناء وأحسنه، وفرشت بأحسن الفرش وأفخره، وأعدّ فيها ضروب الأطعمة والأشربة والملابس والمآرب الّتي يحتاج إليها ولا يستغنى عنها، ووضع كلّ شيء من ذلك موضعه على صواب من التقدير، وحكمة من التدبير، فجعلوا يتردّدون فيها يمينا وشمالا، ويطوفون بيوتها إدبارا وإقبالا، محجوبة أبصارهم عنها، لا يبصرون هيئة الدار وما أعدّ فيها، وربّما عثر بعضهم بالشيء الّذي قد وضع موضعه وأعدّ للحاجة إليه، وهو جاهل بالمعنى فيه، ولما أعدّ، ولما ذا جعل كذلك، فتذمّر وتسخّط وذمّ الدار وبانيها، فهذه حال هذا الصنف في إنكارهم ما أنكروا من أمر الخلقة وثبات الصنعة، فإنّهم لمـــّـا عزبت أذهانهم عن معرفة الأسباب والعلل في الأشياء صاروا يجولون في هذا العالم حيارى، ولا يفهمون ما هو عليه من إتقان خلقته، وحسن صنعته، وصواب تهيئته، وربّما وقف بعضهم على الشيء فجهل سببه والإرب فيه، فيسرع إلى ذمّه ووصفه بالإحالة والخطأ، كالّذي أقدمت عليه المانويّة الكفرة، وجاهرت به الملاحدة الماردة الفجرة، وأشباههم من أهل الضلال.
يا مفضّل، أوّل العبر والأدلّة على البارئ تهيئة هذا العالم، وتأليف أجزائه ونظمها على ما هي عليه. فإنّك إذا تأمّلت العالم بفكرك وميّزته بعقلك، وجدته كالبيت المبنيّ المعدّ فيه جميع ما يحتاج إليه عباده، فالسماء مرفوعة كالسقف، والأرض ممدودة كالبساط، والنجوم منضودة كالمصابيح، والجواهر مخزونة كالذخائر، وكلّ شيء فيها لشأنه معدّ، والإنسان كالمملّك ذلك البيت، والمخوّل جميع ما فيه، وضروب النبات مهيّأة
لمآربه، وصنوف الحيوان مصروفة في مصالحه ومنافعه.
ففي هذا دلالة واضحة على أنّ العالم مخلوق بتقدير وحكمة ونظام وملاءمة، وأنّ الخالق له واحد، وهو الّذي ألّفه ونظمه بعضا إلى بعض، جلّ قدسه، وتعالى جدّه، وكرم وجهه، ولا إله غيره، تعالى عمّا يقول الجاحدون، وجلّ وعظم عمّا ينتحله الملحدون.
وسنبدأ يا مفضّل ؛ بذكر خلق الإنسان فاعتبر به، فأوّل ذلك ما يدبّر به الجنين في الرحم، وهو محجوب في ظلمات ثلاث : ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة ؛ حيث لا حيلة عنده في طلب غذاء، ولا دفع أذى، ولا استجلاب منفعة، ولا دفع مضرّة ؛ فإنّه ليجري إليه دم الحيض ما يغذوه كما يغذو الماء النبات، فلا يزال ذلك غذاءه حتّى إذا كمل خلقه، واستحكم بدنه، وقوي أديمه على مباشرة الهواء، وبصره على ملاقاة الضياء، هاج الطلق بأمّة فأزعجه أشدّ إزعاج، وأعنفه حتّى يولد، فإذا ولد صرف ذلك الدم الّذي كان يغذوه من دم أمّه إلى ثدييها، فانقلب الطعم واللون إلى ضرب آخر من الغذاء، وهو أشدّ موافقة للمولود من الدم، فيوافيه في وقت حاجته إليه، فحين يولد قد تلمّظ شفتيه طلبا للرضاع فهو يجد ثديي أمّه كالإداوتين المعلّقتين لحاجته، فلا يزال يغتذي باللبن مادام رطب البدن، رقيق الأمعاء، ليّن الأعضاء، حتّى إذا تحرّك واحتاج إلى غذاء فيه صلابة ليشتدّ ويقوى بدنه، طلعت له الطواحن من الأسنان والأضراس ليمضغ الطعام، فيلين عليه، ويسهل له إساغته، فلا يزال كذلك حتّى يدرك، فإذا أدرك وكان ذكرا
طلع في وجهه الشعر، فكان ذلك علامة الذكر(١) إلى آخره.
أقول : حديث المفضّل طويل الذيل، لكنّه محتو لبعض التدبيرات الإلهيّة، والتربيات الربّانيّة المصنوعة في الإنسان والحيوانات من السباع والبهائم والطير والهوامّ وكلّ ذي روح من الأنعام والنبات والشجر والحبوب والبقول، وفي الصنائع السمائيّة، والبدائع الفلكيّة، والفوائد الفصوليّة، والخواصّ الأرضيّة، وغير ذلك، فعليك بالتدبّر.
المرصد الرابع : في بيان ( الْعالَمِينَ )
وفيه مقامان :
المقام الأوّل : في معناه وما يتعلّق به
فنقول : المشهور أنّ «العالمين» جمع «للعالم» وذلك لا يخلو عن إشكال ؛ إذ العالمين ـ على ما قيل ـ دالّ على العقلاء فقط، والعالم دالّ عليهم وعلى غيرهم، فلا يكون جمعا لاشتراط الزيادة في الجمع. فتأمّل.
والحقّ أنّه اسم جمع للعالم ؛ وهو ما سوى الباري على المشهور، والقول بأنّه اسم لكلّ صنف وأهل كلّ قرن منقول عن بعض.
وعن بعض أنّه خاصّ بما يعقل من الملائكة والجنّ والإنس.
وعن بعض أنّه خاصّ بالجنّ والإنس، لقوله :( لِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيراً ) (٢)
__________________
(١) انظر خبر المفضّل بن عمر ؛ المشتهر بـ «توحيد المفضّل» في : بحار الأنوار ٣ : ٥٧ ـ ١٥٢.
(٢) الفرقان : ١.
وفيه نظر لقوله : بعثت على كلّ أسود وأحمر.
وعن بعض أنّه الإنس خاصّة، لقوله :( أَتَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ ) (١) وفيه إشكال لاحتمال التبعيض في كلمة «من».
وعن بعض أنّه هو الجسمانيّ المنحصر في الفلك العلويّ، والعنصر السفليّ، لقوله :( رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا ) (٢) في جواب قوله( وَما رَبُّ الْعالَمِينَ ) (٣) .
وقريب منه ما قيل : من أنّ العالم المصنوع اثنان : المادّيّات والمجرّدات، والكائن في الأوّل الجسم والفلك والعنصر، وفي الثانية الملائكة المسمّاة بالملأ الأعلى، والعقول والنفوس والأرواح البشريّة، نقله صفيّ الدين الطريحيّ النجفيّ في «مجمع البحرين».
وبالجملة : «العالم» ـ على ما قاله الطبرسيّ وغيره ـ جمع لا مفرد له من لفظه ؛ كالنفر والجيش، واشتقاقه من العلامة، لأنّه يدلّ على صانعه.
وقيل : إنّه من العلم، لأنّه اسم يقع على ما يعلم.
أقول : وهو الموافق لما قاله الغزاليّ في «الكشف» من أنّ العالم في الوضع اللغويّ اسم لما يعلم به شيء، ومشتقّ من العلم على الأظهر، كالخاتم لما يختم به، فعلى هذا كلّ موجود عالم، لأنّه ممّا يعلم به شيء. انتهى.
__________________
(١) الشعراء : ١٦٥.
(٢) مريم : ٦٥.
(٣) الشعراء : ٢٣.
وقوله «العالم في الوضع اللغويّ إلى آخره» مخالف لما قاله الطبرسيّ من أنّ العالم في عرف اللغة عبارة عن جماعة من العقلاء، لأنّهم يقولون : جاء في عالم من الناس، ولا يقولون في عالم من البقرة. انتهى.
ويمكن الجمع بأن يقال مراد الغزاليّ بالوضع اللغويّ هو ما تعارف في لغات الناس وألسنتهم ؛ كما أشار إليه الطبرسيّ بقوله : وفي المتعارف بين الناس عبارة عن جميع المخلوقات. انتهى.
وبقي هنا كلام آخر، وهو أنّ العالم وضع للجميع، فكيف يطلق على نوع منه؟
ويجاب بأنّ إطلاق العالم على مجموع أجزاء الكون يكون من باب إطلاق القرآن على كلّ سورة منه، بل آية فيها، وكإطلاق الماء على البحر الخاصّ، فلذا يصحّ أن يقال في جمع «العالم» : «العوالم» كما يقال في «الماء» : «المياه».
فلو قيل : قد مرّ من كلام الطبرسيّ أنّه لا يقال جاء عالم من البقرة مع أنّها أيضا من أجزاء العالم، فلا يصحّ القياس المذكور في القرآن والماء.
قلنا : أوّلا إنّا لا نسلّم عدم ذلك الإطلاق في غير العاقل.
وثانيا : إنّ تغليب استعمال العالم في بعض الأفراد المعظمة لا ينافي عدم جواز الاستعمال في الآخر، كيف وقد نسب تربيته تعالى إلى العالمين وهم العقلاء على قول مع أنّ تربيته عامّة لجميع الممكنات، فالتخصيص إمّا لشرافتهم وأفضليّتهم على الغير، وإمّا للتغليب، وهو مطّرد عند الفصحاء، وإمّا لأنّ كلّا منهم بمنزلة العالم الكبير ؛ إذ كلّ ما اندرج فيه وجعل عليه فقد اندرج في العالم الصغير الّذي هو الإنسان الّذي كان نسخة للكبير، فلذا قال مولى السالكين أمير المؤمنين عليه السلام :
أتزعم أنّك جرم صغير |
وفيك انطوى العالم الأكبر(١) |
وقال بعض :
آنچه در عالم كبير بود |
همه در جبّه ورداى من است |
فتخصيص التربية ببعض الأفراد لخصوصيّة لا ينافي تربيتها للجميع، فتخصيص إطلاق العالم على العقلاء غير مناف لصحّة إطلاقه على غيرهم على سبيل الحقيقة كالإنسان، فإنّ إطلاقه على الحيوان الناطق الّذي كان له رأسان غير شائع، مع أنّ إطلاق الإنسان عليه حقيقة.
وثالثا : بأنّ إطلاق «العالم» على ما يعقل إنّما هو خاصّ بالعرف وهو لا ينافي الوضع اللغويّ ؛ إذ هو فيه مستعمل لجميع الأجزاء على السويّة ؛ كما أنّ «الرحمن» موضوع في اللغة لكلّ من يرقّ قلبه، لكنّه في العرف لا يطلق على غير «الله» عزّ وجلّ.
المقام الثاني : في ذكر بعض العوالم وما يتعلّق بذلك إجمالا
فنقول : لله عزّ وجلّ عوالم كثيرة لا يحصي جزئيّاتها أحد من الخلائق، وإنّما علمه عند الله، لكنّ العالم ينقسم مجملا :
إلى «الغيب» وهو ما غاب عن مشاهدتنا.
وإلى «الشهادة» وهي ما يشاهد، وقد خلقها تعالى في ستّة أيّام عرفيّة على المشهور.
ونقل المجلسيّ في البحار عن بعض أنّه خلقها في ستّة آلاف عام ؛
__________________
(١) ديوان الإمام عليّ عليه السلام : ١٧٥.
بدليل قوله( وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ) (١) .
وبالجملة : الأخبار في كثرة العوالم والخلائق متواترة كما في الوافي عن ابن عبّاس : إنّ لله عزّ وجلّ ثلاثمائة عالم وبضعة عشر عالما خلف قاف، وخلف البحار السبعة ؛ لم يعصوا الله طرفة عين قطّ، ولم يعرفوا آدم ولا ولده، كلّ عالم منهم يزيد على ثلاثمائة وثلاثة عشر آدم وما ولد(٢) .
وفيه : عنه قال : دخل علينا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ونحن في المسجد حلق حلق، فقال لنا : فيم أنتم؟ قلنا : نتفكّر في الشمس كيف طلعت وكيف غربت؟ قال : «أحسنتم كونوا هكذا، تفكّروا في المخلوق ولا تفكّروا في الخالق، فإنّ الله خلق ما شاء لما شاء، وتعجبون من ذلك أنّ وراء قاف سبعة بحار، كلّ بحر خمسمائة عام، ومن ذلك سبع أرضين يضيء نورها لأهلها، ومن وراء ذلك سبعين ألف أمّة خلقوا من ريح، وطعامهم من ريح، وشرابهم من ريح، وثيابهم من ريح، وآنيتهم من ريح، ودوابّهم من ريح، لا تستقرّ حوافر دوابّهم إلى الأرض إلى قيام الساعة، أعينهم في صدورهم، ينام أحدهم نومة واحدة وينتبه ورزقه عند رأسه، ومن وراء ظلّ العرش سبعون ألف أمّة ما يعلمون أنّ الله خلق آدم ولا ولد آدم ولا إبليس ؛ ولا ولد إبليس وهو قوله :( وَيَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ ) (٣) (٤) .
وفيه : سئل النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم عن القاف وما خلفه، قال :
__________________
(١) الحجّ : ٤٧.
(٢) تفسير القمّيّ ٢ : ٤٠٩.
(٣) النحل : ٨.
(٤) بحار الأنوار ٥٤ : ٣٤٨.
خلفه سبعون أرضا من ذهب، وسبعون أرضا من فضّة، وسبعون أرضا من مسك ؛ خلفه سبعون أرضا كأنّها الملائكة، لا يكون فيها حرّ ولا برد، وطول كلّ أرض مسيرة عشرة آلاف سنة.
قيل : وما خلف الملائكة؟
قال : حجاب من ظلمة.
قيل : وما خلفه؟
قال : حجاب من ريح.
قيل : وما خلفه؟
قال : حجاب من نار.
قيل : وما خلفه؟
قال : حجاب من نور.
قيل : وما خلفه؟
قال : حيّة محيطة بالدنيا كلّها، تسبّح الله إلى يوم القيامة، وهي ملك الحيّات كلّها.
قيل : وما خلفه؟
قال : حجاب من نور.
قيل : وما خلفه؟
قال : علم الله وقضاؤه(١) .
وفيه : عن الحسن بن عليّ عليه السلام : إنّ لله مدينة في المشرق ومدينة
__________________
(١) جامع الأخبار : ١٢٦.
في المغرب، على كلّ واحد سور من حديد، وفي كلّ سور سبعون ألف مصراع، يدخل في كلّ مصراع سبعون ألف لغة آدميّ ليس منها إلّا لغة مخالفة الاخرى، وما منها لغة إلّا وقد علمناها، وما فيهما وما بينهما ابن نبيّ غيري وغير أخي، وأنا الحجّة عليهم(١) .
وفيه : عن أبي جعفر عليه السلام : إنّ من وراء شمسكم هذه أربعين عين شمس، ما بين شمس إلى شمس أربعون عاما، فيها خلق كثير ما يعلمون أنّ الله خلق آدم أم لم يخلقه، وإنّ من وراء قمركم هذا أربعين قمرا ما بين قمر إلى قمر مسيرة أربعين يوما، فيها خلق كثير ما يعلمون أنّ الله خلق آدم أم لم يخلقه، قد ألهموا كما ألهمت النحل لعنة «الأوّل» و «الثاني» في كلّ وقت من الأوقات، وقد وكّل بهم ملائكة متى لم يلعنوهما عذّبوا(٢) .
وفيه : عن أبي الحسن عليه السلام : إنّ لله خلف هذا النطاق زبرجدة خضراء، فمن خضرتها اخضرّت السماء.
قيل : ما النطاق؟
قال : الحجاب، ولله وراء ذلك سبعون ألف عالم أكثر من عدد الجنّ والإنس وكلّهم يلعن فلانا وفلانا(٣) .
وفيه : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنّ لله مدينة بالمشرق اسمها «جابلقا» لها إثنا عشر ألف باب من ذهب، بين كلّ باب إلى صاحبه مسيرة
__________________
(١) بصائر الدرجات : ٤٩٢.
(٢) بصائر الدرجات : ٤٩٣.
(٣) بصائر الدرجات : ٤٩٢.
فرسخ، وعلى كلّ باب برج فيه إثنا عشر ألف مقاتل، يهلبون الخيل ويشحذون السيوف والسلاح ؛ ينتظرون قيام قائمنا، وإنّ لله بالمغرب مدينة يقال لها «جابرسا» لها اثنا عشر ألف باب من ذهب، بين كلّ باب إلى صاحبه مسيرة فرسخ، على كلّ باب برج فيه إثنا عشر ألف مقاتل يهلبون الخيل ويشحذون السلاح ؛ ينتظرون قائمنا(١) .
أقول : وأمثال تلك الأخبار في كتب الآثار أكثر من رمل القفار، فمن يرجوها فليطلب من المفصّلات.
فائدة :
قالت الصوفيّة : العوالم أربعة ؛ عالم الشهادة المحسوسة، وعالم الغيب، وعالم الملكوت، وعالم الجبروت، وهو عالم الذات الأحديّة القديمة.
وقيل : تسمّى صفاتها بعالم الملكوت، وهنا أبحاث كثيرة ذكرت في المطوّلات، وذكرنا بعضها في بعض كتبنا العرفانيّة، فعليك بالرجوع إليها.
خاتمة : في بعض ما يتعلّق بـ( الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ )
فنقول : قد مرّ تفصيلهما في «البسملة» فإن قيل ما وجه التكرار؟ لقلنا : لا تكرير ؛ إذ هما في «البسملة» كانا تاليين لعالم السبب المفاد من «الباء» والنسب المفاد من الإضافة، لكنّهما هنا ليسا كذلك، فهما على الأوّل من صفات الفعل، وعلى الثاني من صفات الذات. فليتأمّل.
ولو سلّم التكرار، فهو للمبالغة ـ على ما قاله الطبرسيّ رحمه الله في «المجمع».
__________________
(١) بحار الأنوار ٥٤ : ٣٣٤ الحديث رقم ١٩ نقلا عن «منتخب البصائر».
ونقل عن الرمّانيّ أنّه قال : في الأوّل ذكر العبوديّة، فوصل ذلك بشكر النعم الّتي بها يستحقّ العبادة، وهاهنا ذكر الحمد، فوصله بذكر ما يستحقّ الحمد من النعم، فليس فيه تكرار.
أقول : هذا الوجه ليس بوجيه، لأنّه إن أراد من ذكر العبوديّة التصريح بذكرها فغير مسلّم قطعا، بل التصريح إنّما هو هنا لقوله :( إِيَّاكَ نَعْبُدُ ) وإن أراد من الذكر : الذكر التقديريّ، وهو ذكر الاستعانة بالتسمية نظرا إلى أنّها عبادة، فمسلّم، لكنّه معارض بالحمد، فإنّه أيضا عبادة. على أنّ الاستعانة مذكورة هنا أيضا صريحا كما في قوله :( إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) ، فتخصيص تقابل الرحمة بالعبادة في البسملة غير وجيه. فليتأمّل.
ويمكن أن يقال : إنّ المراد بالأوّل الرحمة القديمة الّتي هي من صفة الذات من دون وجود خلق يرحم بها، وذلك هو العدالة القديمة الذاتيّة المقابلة للظلم، وبالثاني الرحمة الحادثة الّتي حدثت بحدوث الخلق، فلذا تليها لقوله :( رَبِّ الْعالَمِينَ ) ليدلّ أنّه تعالى هو العدل الّذي وسعت رحمته كلّ شيء، بسبب تربيته للجميع بقدر القابليّة.
الفصل الرابع
في بعض ما يتعلّق بتفسير قوله عزّ وجلّ( مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ )
وفيه مقالات.
المقالة الأولى : في ما يتعلّق بإعرابه
فنقول : القراءة المشهورة جرّ «الكاف» من «مالك» بل نسبها الطبرسيّ إلى جميع القرّاء، ليكون صفة «لله» و «للرحيم» على الاختلاف.
ونقل الطبرسيّ عن الأعمش نصب «الكاف» أيضا ؛ إمّا لكونه من باب القطع وحذف الفعل، وإمّا لكونه منادى المضاف وحذف آلة النداء على حدّ قوله :( يُوسُفُ أَعْرِضْ ) (١) فتأمّل، وكذا في( رَبِّ الْعالَمِينَ ) .
فالمعنى : إنّ الحمد لله، ولك الحمد يا ربّ العالمين، ويا مالك يوم الدين.
و( يَوْمِ الدِّينِ ) مجرور بالإضافة، وقد ينصب على قراءة «ملك» فعلا ماضيا على المفعوليّة وعلى قراءة «مالك وملك» أيضا على الظرفيّة.
ويحتمل أن يقال إضافة «المالك» أو «الملك» إلى «يوم» هو إضافة الشيء
__________________
(١) يوسف : ٢٩.
إلى المفعول به، على حدّ قوله :( وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ) (١) أي يعلم الساعة ويعرفها، أو إلى الظرف بتقدير المفعول، أي هو مالك يوم الدين القضاء والحكم، ويؤيّده قوله :( وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ) (٢) . انتهى.
وقد يقرأ «المالك» ملك بسكون «اللام» وهو نادر. قيل هو مخفّف «ملك» بكسر «اللام» كالفخذ في فخذ، وهل يمال مدّ «المالك» أم لا؟ قاعدة الإمالة يقتضيها ويعمّها، ولا يمنعها ما قاله الطبرسيّ من أنّه لم يمل أحد ألف «مالك». انتهى.
إلّا أن يحمل على وفاق الحجازيّين الّذين منعوا الإمالة مطلقا، وأمّا التميميّون فيجعلونها من المحسّنات مطلقا، لكنّ الاحتياط عدم الإمالة في «المالك» بل في القرآن، لأنّ ترك المحسّن الّذي يقابله القول بالمنع أولى. فليتأمّل.
المقالة الثانية : في معنى «المالك» و «الملك»
فنقول : يقال : ملكه يملكه أي سلّطه عليه بحيث لا ينبغي لغيره أخذه بدون إذنه، والحقّ مالك الملك أي الملك بيده يتصرّف فيه حيث يشاء، والملك هو السلطان ذو المجد والعظمة، له الكبرياء، وله تمام الملك الجامع لأصناف المملوكات من الأرضين والسماوات.
وقيل : أي القادر الواسع الّذي له السياسة العظمى والتدبير الأكبر.
__________________
(١) الزخرف : ٨٥.
(٢) الانفطار : ١٩.
وقيل : أي المتصرّف بالأوامر والنواهي.
وقيل : أي المستغني في ذاته وصفاته عن الجميع مع احتياجه إليه.
قال الكفعميّ في «الرسالة الواضحة» : إن وصف الله أنّه ملك كان ذلك من صفات الذات، وإن وصف بأنّه مالك كان من صفات الأفعال.
أقول : لعلّ نظره في ذلك إلى أنّ المالك للملك يحتاج إلى وجوده، وليس في الأزل معه تعالى شيء حتّى يملكه.
وفيه : إنّ ذلك منقوض بالملك ؛ إذ معناه السلطان وسلطنة الشيء متوقّف على وجود الرعايا والأملاك، فتخصيص الأوّل بصفة الفعل دونه غير وجيه، والأشبه أنّ المالك أيضا من صفة الذات ؛ إذ معناه حينئذ القادر على التصرّف في ملكه، والقدرة من صفة الذات، وإلّا يلزم أن لا يكون تعالى عالما في الأزل، فكان العلم من صفة الفعل ؛ فالحقّ أنّ لجميع الصفات معنيين : معنى يرجع إلى الذات، ومعنى يعود إلى الفعل. فليتأمّل، فإنّه دقيق.
عائدة :
من أراد دوام الملك والسلطنة والغنى فليدمن على ذكر «المالك والملك»، قيل : ذلك لمن واظب على ذكره في كلّ يوم أربعة وستّين مرّة.
المقالة الثالثة : في أنّ الأحسن في القراءة هو مالك أو ملك، ويظهر من ذلك
الفرق بينهما أيضا
فنقول : قد اختلف في ذلك على قولين :
الأوّل : إنّ الأمدح في القراءة هو «الملك» بحذف «الألف» لوجوه :
الأوّل : العموم، وتوضيحه أنّه ليس ملك إلّا وهو مالك، والعكس منتف بالضرورة.
الثاني : إنّ أمر الملك نافذ على المالك، بل هو رعيّته بالضرورة لا بالعكس ؛ كما لا يخفى.
الثالث : إنّ ما في تصرّف الملك وحيطة ملكه أكثر ممّا في يد المالك. فليتأمّل.
قال الطبرسيّ : من قرأ «ملك» قال : إنّ هذه الصفة أمدح، لأنّه لا يكون إلّا مع التعظيم والاحتواء على الجمع الكثير. واختاره ابن السرّاج، وقال : إنّ «الملك» الّذي يملك الكثير من الأشياء ويشارك غيره من الناس في ملكه بالحكم عليه، وكلّ ملك مالك وليس كلّ مالك ملكا، وإنّما قال تعالى( مالِكَ الْمُلْكِ ) (١) لأنّه يملك ملوك الدنيا وما ملكوا، فمعناه إنّه يملك ملك الدنيا، فيؤتي الملك فيها من يشاء، فأمّا يوم الدين، فليس إلّا ملكه، وهو ملك الملوك يملكهم كلّهم، وقد يستعمل هذا في الناس يقال : فلان ملك الملوك وأمير الأمراء. انتهى.
الرابع : قوله تعالى :( فَتَعالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ) (٢) . فليتأمّل.
الثاني : إنّ الأمدح والأحسن في القراءة «مالك» بالألف لوجوه :
منها : قوله تعالى :( مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ ) (٣) وجوابه يظهر من كلام ابن السرّاج.
__________________
(١) آل عمران : ٢٦.
(٢) طه : ١١٤.
(٣) آل عمران : ٢٦.
ومنها : إنّه يقال مالك الدراهم، ولا يقال ملك الدراهم.
والجواب أوّلا : إنّ ذلك العموم لا يكافي العموم في «ملك» وقد مرّ.
وثانيا بأنّ نسبة المالك إلى تلك الجزئيّات لا تدلّ على أمد حيّته في القراءة ؛ إذ الملك لا ينسب إلّا إلى المعظّم فيقال : ملك الدهر، ولا يقال : مالك الدهر، ويقال : ملك الزمان، ولا يقال : مالكه، ويوم الدين من الظروف الحقيقيّة، فنسبة الملك إليه أولى من نسبة المالك، على أنّ الملك أنسب بعد ذكر «الربّ» إذ هو بمعنى السيّد، يقال : سيّد القوم أي عظيمهم وملكهم، ومعنى السيّد هو الملك الّذي يجب طاعته ـ على ما قاله الكفعميّ وصاحب «العدّة».
فإرداف الملك للربّ المتقاربين في المعنى أولى من إردافه للمالك له، وذلك أوفق بالمعنى ؛ إذ قوله تعالى :( رَبِّ الْعالَمِينَ ) يدلّ على أنّه ملك أهل الدنيا وسلطانهم، فيفتقر إلى ما يدلّ على أنّه ملك في الآخرة أيضا، فأشار بقوله تعالى : ملك يوم الدّين إلى آخره.
فالأمدح في القراءة عندي هو «ملك» بدون الألف ولا «مالك» معها، وإن كانا في حقّ الله تعالى على سواء ؛ إذ مالكيّته عين ملكيّته على الأقوى ؛ وفاقا لابن حاتم أيضا ـ على ما نقل عنه الكفعميّ في «الرسالة الواضحة» ـ وذلك أي الأمدحيّة إنّما هي باعتبار المناسبة الظاهريّة وهو أحسن. فليتأمّل.
ومنها : إنّ المالك للشيء يلزم كونه مملوكا له، والملك قد لا يكون مالكا كما يقال هو ملك العرب أي سلطانهم غير كونهم في ملكه، فلو قرأ «ملك» لم يمحّض الدلالة على أنّ الخلق مملوكه.
والجواب : إنّ ذلك معارض بما مرّ من أنّ المالك للشيء لا يلزم كونه ملكا له، فلو قرأ «مالك» يلزم محذوران : الأوّل عدم التمحيض للدلالة على أنّه سلطان في يوم الجزاء، والثاني ما مرّ من عدم التناسب للربّ، فارتكاب محذور واحد أولى من ارتكاب المحذورين، على أنّه قد مرّ أنّ الملك أملك في الأشياء، وأشدّ تصرّفا فيها من المالك، فالتمليك الملكيّة أقوى من التملّك المالكيّة، فلا يلزم الحذر أصلا.
فلو قيل : قراءة «المالك» أشهر فهي المتعيّن.
قلنا : أوّلا بمنع حجّيّة الشهرة، وثانيا بأنّ تلك القراءة ما قرأها إلّا عاصم والكسائيّ وخلف ويعقوب الحضرميّ، وقرأ الباقون كلّهم «ملك» بحذف الألف على ما نقل عنهم الطبرسيّ ؛ فقراءة الأشهر تعارض قراءة الأكثر. فليتأمّل.
المقالة الرابعة : في تفسير قوله( يَوْمِ الدِّينِ )
فنقول : قد اختلف في ذلك اليوم، فقيل : المراد به «الوقت» كما في قوله تعالى :( خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ) (١) إلى آخره.
وقيل : المراد امتداد الضياء واستدامته.
واختلف في «يوم الدين» أيضا ففي «المجمع» عن الباقر عليه السلام أنّه يوم الحساب، أي يوم يحاسب العبد عند الله ويستقرّ كلّ من أهل الجنّة والنار فيهما.
__________________
(١) الأعراف : ٥٤.
والمشهور أنّه بمعنى يوم الجزاء، وهو قريب من الأوّل، يقال :
«كما تدين تدان» أي كما تجزي تجزى، ويقال : «الحقّ ديّان» أي يجزي العباد بأعمالهم إلى آخره.
ويؤيّده قوله تعالى :( الْيَوْمَ تُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ ) (١) و( الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) (٢) .
ونقل الطبرسيّ عن الجبّائيّ أنّه تعالى أراد به يوم الجزاء على الدين.
وعن محمّد بن كعب أنّه أراد منه يوم لا ينفع إلّا الدين. فتأمّل.
وبالجملة : هذا اليوم يوم لا ينفع مال ولا بنون، ويوم يفرّ المرء من أخيه وأمّه وأبيه وفصيلته الّتي تؤويه، ويوم يقوم الأنبياء حيارى وهم بأنفسهم خائفون، وعند الميزان قائمون، فويل لنا وواها منّا، كيف لا نتذكّر يوم تبلى السرائر، وتهتك الأستار.
وفي «مصباح الشريعة» : لو لم يكن للحساب مهولة إلّا حياء العرض على الله وفضيحة هتك الستر على المخفيّات لحقّ للمرء أن لا يهبط من رؤوس الجبال، ولا يأوي إلى عمران، ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام عن اضطراب متّصل بالتلف(٣) .
وفيه عن أبي ذرّ رحمه الله : ذكر الجنّة موت، وذكر النار موت، فواعجبا لنفس تحيا بين موتين.
__________________
(١) غافر : ١٧.
(٢) الجاثية : ٢٨.
(٣) مصباح الشريعة : ٨٥.
وفيه : إنّ يحيى بن زكريّا كان يفكّر في طول الليل من أمر الجنّة والنار فيسهر ليلته ولا يأخذه النوم، ثمّ يقول عند الصباح : أللّهمَّ أين المفرّ وأين المستقرّ، أللّهمّ إليك(١) إلى آخره.
والأخبار في كيفيّة يوم الحساب والجزاء متكاثرة.
__________________
(١) مصباح الشريعة : ٨٥.
الفصل الخامس
في تفسير قوله تعالى( إِيَّاكَ نَعْبُدُ )
فنقول : لو قدّرنا في أوّل السورة «قولوا يا عبادي» ففي هذا الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب بخلاف ما لو قدّرناه هنا خاصّة، ولكن يدلّ على الأوّل ما رواه الإمام أبو محمّد الحسن العسكريّ عليه السلام في تفسيره عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : لقد سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول : قال الله : قسمت الحمد بيني وبين عبدي، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل،إذا قال العبد :( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) قال الله عزّ وجلّ : بدأ عبدي باسمي، حقّ عليّ أن أتمّم له أموره، وأبارك له في أحواله.
فإذا قال :( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ) قال الله : حمدني عبدي وعلم أنّ النّعم الّتي له من عندي، وأنّ البلايا الّتي اندفعت عنه فبطولي، أشهدكم يا ملائكتي أنّي أضيف له نعم الدنيا إلى نعيم الآخرة، وأدفع عنه بلايا الآخرة كما دفعت عنه بلايا الدنيا.
وإذا قال :( الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) قال الله : شهد لي عبدي بأنّي «الرحمن الرحيم» أشهدكم لأوفّرنّ من رحمتي حظّه، ولأجزلنّ من عطائي نصيبه.
فإذا قال( مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ) قال الله : أشهدكم كما اعترف بأنّي أنا الملك
يوم الدين لاسهّلنّ يوم الحساب عليه حسابه، ولاثقلنّ حسناته، ولأتجاوزنّ عن سيّئاته.
فإذا قال العبد :( إِيَّاكَ نَعْبُدُ ) قال الله : صدق عبدي إيّاي يعبد، أشهدكم لاثيبنّه على عبادته ثوابا يغبطه كلّ من خالفه في عبادته لي.
فإذا قال :( وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) قال الله : بي استعان عبدي وإليّ التجأ، أشهدكم لأعيننّه في أمره ولاغيثنّه في شدائده، ولآخذنّ بيده يوم نوائبه.
فإذا قال :( اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ ) قال الله : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، قد استجبت لعبدي وأعطيته ما أمّل وأمنته ممّا منه وجل(١) . انتهى.
ولا ينافيه ما في هذا التفسير من تخصيص هذا الكلام بهذا التقدير حيث قال عند ذكره قال الله : قولوا يا أيّها الخلق المنعم عليهم( إِيَّاكَ نَعْبُدُ ) أيّها المنعم علينا، نطيعك مخلصين مع التذلّل والخضوع بلا رياء ولا سمعة إلى آخره. والوجه ظاهر للمتأمّل.
وليس في قوله( وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) (٢) ومابعده التفات لجريان الكلام على أسلوبه المتعارف.
والمراد بالالتفات على اصطلاح جمهور أرباب المعاني هو التعبير عن معنى بطريق من المتكلّم والخطاب والغيبة بعد التعبير عنه بطريق آخر منها بشرط أن يكون التعبير الثاني على خلاف مقتضى الظاهر.
وعن السكاكيّ أنّه عبارة عن العدول عن مقتضى الظاهر مطلقا سواء عبّر
__________________
(١) تفسير الإمام العسكريّ : ٥٨.
(٢) تفسير الإمام العسكريّ : ٣٩، مجموعة ورّام ٢ : ٩٥.
عنه بطريق آخر غير التعبير السابق أو لم يعبّر، وفائدة الالتفات هو التفنّن في التعبير وزيادة التمكّن والتقوية وغير ذلك.
ولعلّ النكتة في المقام ترقّي القاري عن الغيب إلى الشهود والعيان، بمعنى أنّه في مقام كأنّه يرى الله، فإنّه إن لم يكن يراه فهو تعالى يراه ؛ كما ورد في الحديث : اعبد الله كأنّك تراه إلى آخره.
و( إِيَّاكَ ) بمجموعه ضمير على قول، و «إيّا» خاصّة ضمير واللواحق حروف زيدت لبيان الحال على قول آخر، وإنّما قدّم لإفادة القصر والاختصاص كما في تقديم كلّ ما حقّه التأخير، ففيه إشارة إلى التوحيد في العبادة والبعد عن الرياء الّذي هو شرك كما ورد في جملة من الأخبار.
والعبادة : الذلّة والاستكانة والخضوع الكامل لدى حضرة المبعود، وينبغي للعبد أن يذعن بأنّ الله هو المستحقّ لأن يعبد، لأنّ له العظمة والكبرياء خاصّة لا يشاركه في ذلك أحد من عباده ؛ كما أشار إليه في الحديث القدسيّ، فإذا عبد العبد معترفا بهذا المعنى كانت عبادته عبادة الأحرار لا عبادة العبيد والاجراء ؛ كما في بعض الأخبار.
وفي العدول عن «أعبد» إلى «نعبد» إدراج نفسه في أنفس العابدين، وخلط عبادته بعبادة المخلصين لتقع مقبولة عند ربّ العالمين، لأنّ المتاع المعيب إذا كان في جملة من الأمتعة الصحيحة لا يجوز ردّه إلّا بردّ الجميع، والله عزّ وجلّ أكرم من أن يردّ عبادة هؤلاء بعيب عبادة واحد، فلا محالة يقبل الجميع. ومن هنا وردت أخبار كثيرة مرغّبة في صلاة الجماعة، ولا ريب أنّ الرحمة إذا نزلت عمّت.
الفصل السادس
في تفسير قوله تعالى( وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ )
وفيه مقالات.
المقالة الاولى : في إعرابه
فنقول : الأظهر أنّ «الواو» عطف على ما سبقه، وقيل : هي للحاليّة أي أعبدك مستعينا بك في عبادتي، والمشهور في اللغات فتح «النون» من «نستعين» والكسر لغة نادرة، وهنا تفاصيل ذكرت في قوله( إِيَّاكَ نَعْبُدُ ) والتكرير موجب للتحيّر، والإعادة لا تجدي زيادة الإفادة.
المقالة الثانية : في معنى الاستعانة، ومجمل من التوكّل والتفويض
فنقول : في قوله( إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) إشارة إلى أنّه لا ينبغي للعبد أن يستعين ويطلب الظهير في الحوائج الدينيّة والدنيويّة عن غير الحقّ تعالى، بل عليه أن يقتصر استعانته بالله، ويفتقر إلى مدده ومعاونته، ويستغني بذلك عن غيره تعالى، بل ينبغي عليه أن لا يرى لنفسه حولا عن المعصية ولا قوّة على الطاعة إلّا بمدده تعالى.
فعليك بالتوكّل وتفويض أمورك وحوائجك بالله من غير التفات إلى غيره وعدم رؤية الغير مستحقّا لأن يطلب منه قضاء الحوائج، بل علم أنّ الكلّ مفتقر محتاج وهو الغنيّ الّذي لا يفتقر أبدا، فاعتصم بحبل الله وتمسّك بعروته الوثقى ؛ إذ المتمسّك بها هو المنجي والمعتصم بغيرها من الغرقى. ألا من وكّل حوائجه إلى الله يقضيها بنفسه ولا يكلها إلى غيره ويكفل لرزقه وأمره.
ويؤيّد ذلك ما في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أوحى الله تعالى إلى داوود : ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيّته ثمّ تكيده السماوات والأرض ومن فيهنّ إلّا جعلت له المخرج من بينهنّ، وما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي عرفت ذلك من نيّته إلّا قطعت أسباب السماوات والأرض من بين يديه وأسخت من تحته ولم أبال بأيّ واد تهالك(١) .
وفي «مصباح الشريعة» : المفوّض أمره إلى الله في راحة الأبد والعيش الدائم الرغد، والمفوّض حقّا هو العالي عن كلّ همّة دون الله، كقول أمير المؤمنين :
رضيت بما قسم الله لي |
وفوّضت أمري إلى خالقي |
|
كما أحسن الله فيما مضى |
كذلك يحسن فيما بقي(٢) |
__________________
(١) الكافي ٢ : ٦٣، فقه الرضا : ٣٥٨، مشكاة الأنوار : ١٦.
(٢) مصباح الشريعة : ١٧٥.
المقالة الثالثة : في مجمل من الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين
على طريق الإجمال
فنقول : قد اختلفت الامّة في ذلك على أقوال :
الأوّل : إنّ الله قد أجبر عباده في أفعالهم، فهو خالقها ؛ لقوله تعالى :( اللهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ ) (١) فليس للعبد فيها قدرة، بل هو كالآلة يصيّرها القادر حيث شاء. وذهب إلى ذلك القول بعض الصوفيّة، وأثبت بذلك التوحيد الفعليّ وقال : وكلّ الّذي شاهدته فعل واحد ولا فاعل سواه وكلّ من عنده.
گر رنج به پشت آيد گر راحت اى حكيم |
نسبت مكن به غير كه اينها خدا كند |
وتسمّى تلك الفرقة بـ «الجبريّة» أيضا.
الثاني : إنّ الفعل صادر عن العبد من غير مدد من الله، بل هو مفوّض إليه وليس للحقّ في فعله قدرة أصلا، وتسمّى تلك الفرقة بـ «القدريّة» و «المفوّضة» وهم مجوس هذه الامّة ؛ ولعنت على لسان سبعين نبيّا.
الثالث : إنّ العمل صادر عن العبد مع الخذلان في المعصية عن الله والمعونة في الطاعة، وذلك معنى «الأمر بين الأمرين» وهو الحسنة الّتي بين السيّئتين، وفي قوله تعالى :( إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) إشارة إلى ذلك، لأنّ معناه : إنّي أعبدك مستعينا منك في الطاعة، ومستمدّا منك في العبادة. وفي هذا المقام تفاصيل كثيرة لا يسعها المقام، ونحن ذكرنا بعضها في «أسرار العارفين» و «شمس المشارق» فارجع إليهما.
__________________
(١) الصافات : ٩٦.
الفصل السابع
في تفسير قوله تعالى( اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ )
وفيه مقالات.
المقالة الاولى : في إعرابه وما يتعلّق بذلك
فنقول : قوله( اهْدِنَا ) جملة مستأنفة ويحتمل تعلّقها بما قبله، أي أعبدك رجاء لهدايتك إيّانا إلى الصراط المستقيم والنهج القويم، و «الصراط» على ما يفهم من كلمات اللغويّين والمفسّرين أصله «السراط» بالسين، فابدل صادا للتناسب مع الطاء ؛ إذ هما عن المستعلية السبعة، والقراءة بالسين أيضا جائز مراعاة للأصل. قال الشاعر :
فصدّ عن نهج السراط القاصد
المقالة الثانية : في معنى الهداية وما يتعلّق بذلك
فنقول : الهداية كالدلالة مصدر من «هديته» ولها معان :
منها : الدلالة والإرشاد، يقال : هو هاد أي دالّ مرشد، ويقال : اهدنا أي
أرشدنا ودلّنا، قال الله تعالى :( أَهْدِيَكَ إِلى رَبِّكَ ) (١) يعني أدلّك و( ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ ) (٢) أي دليلا لهم.
ومنها : الثبوت وعدم الزلّة والخطأ في الطريق، يقال : اهدنا أي ثبّتنا، قال الله :( لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا ) (٣) أي لنثبّتنّهم.
ومنها : الثواب، قال الله :( يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمانِهِمْ ) (٤) أي يثيبهم.
فائدة :
اختلفوا في الهداية على أقاويل، فقيل : إنّها هي الموصلة إلى المطلوب من غير واسطة، وقيل : هي إراءة الطريق مطلقا.
وقيل : هي للأوّل إن تعدّت بالنفس كـ( اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ ) وللثاني إن تعدّت بـ «اللام» كقوله تعالى :( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا ) (٥) إلى آخره، وإمّا بـ «إلى» كقوله :( اهْدِنا إِلى سَواءِ الصِّراطِ ) (٦) .
والأظهر عندي أنّ الهداية هي مطلق الإرشاد ؛ كما اختاره صاحب «المفتاح» أيضا، فهي مشتركة بين المعنيين تستعمل فيهما لا في الأوّل دائما، لانتقاضه بنحو قوله تعالى :( فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى ) (٧) ولا في الثاني
__________________
(١) النازعات : ١٩.
(٢) البقرة : ٢.
(٣) العنكبوت : ٦٩.
(٤) يونس : ٩.
(٥) الأعراف : ٤٣.
(٦) ص : ٢٢.
(٧) فصّلت : ١٧.
كذلك، لانتقاضه بقوله :( إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ) (١) ولا في الأوّل عند التعدّي بالنفس وفي الثاني عند التعدّي بالغير، لانتقاضه بقوله :( هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ) (٢) . فليتأمّل.
المقالة الثالثة : في معنى( الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ )
فنقول : قد اختلفوا في ذلك، فقيل : هو «عليّ بن أبي طالب عليه السلام» أي أرشدنا إلى ولايته عليه السلام لننجى، والأخبار الكثيرة دالّات على ذلك.
وقيل : الطريق الواضح المتّسع.
وقيل : هو «الدين الحقّ» المحتوي لجميع ما أمر الله به من التوحيد ولوازمه.
وقيل : هو «الإسلام» فتأمّل.
وقيل : هو «القرآن».
وقيل : هو «النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وأولاده عليهم السلام».
والأظهر أنّ المراد به ما فسّره في قوله :( صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ) إلى آخره، أي اهدنا صراط الأنبياء والصدّيقين من التوحيد والإخلاص وغير ذلك، فإنّهم على الصراط المستقيم والسبيل القويم.
ويؤيّد ذلك : ما روي من : أنّ لله صراطين : صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، فمن قام بالأوّل يقوم بالثاني، ومن عدل عنه يعدل عنه(٣) .
__________________
(١) القصص : ٥٦.
(٢) الإنسان : ٣.
(٣) معاني الأخبار : ٣٢.
الفصل الثامن
في تفسير قوله تعالى( صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ)
وفيه مقالتان.
المقالة الأولى : في ما يتعلّق بإعرابه
فنقول : وقوله( صِراطَ الَّذِينَ ) منصوب إمّا على الصفتيّة «للصراط المستقيم» وإمّا على البدليّة له بدل المطابق، والأوّل عندي أوجه، لعدم لزوم السقوط والتكرار فيه بخلاف الثاني. فليتأمّل.
و( الَّذِينَ ) مجرور بإضافة «صراط» إليه وهو من الموصولات الاسميّة العامّة المشتركة، والصلة «أنعمت» و «عليهم» عائدة يعني يرجع ضميره إليه.
وفيه قراءات نقلها الطبرسيّ رحمه الله :
الاولى ـ وهو المشهور ـ : كسر «الهاء» وسكون الميم.
والثانية : ضمّها كذلك، وهو المرويّ عن حمزة، بل نقل عن يعقوب ضمّ كلّ هاء قبلها ياء ساكنة في التثنية والجمع.
والثالثة : كسر «الهاء» مع ضمّ «الميم».
والرابعة : ضمّهما.
والخامسة : ضمّ «الهاء» وإشباع «الميم» مضمومة، فيقال : عليهموا.
والسادسة : كسر «الهاء» وإشباع «الميم» مكسورة، فيقال : عليهمي.
وقوله :( غَيْرِ الْمَغْضُوبِ ) إلى آخره، لفظة غير مجرورة على القراءة المشهورة، وذكروا في جرّها وجوها :
منها : البدليّة لمجرور «على» في «عليهم».
ومنها : البدليّة «للذين».
ومنها : الوصفيّة «للذين» اختار ذلك السرّاج والزجّاج، وأورد عليهما بأنّ «غير» و «مثل» و «شبه» نكرات دائما وإن أضيفت إلى المعرفة أيضا، لتوغّلها في الإبهام.
وأجاب عن ذلك الزجّاج بأنّ «الذين» ليست معرفة حقيقيّة تامّة، بل هي كالنكرات المعرّفة كالرجل والفرس فإتيان وصفه بـ «غير» غير مضرّ، كما أتى الجملة وصفا للنكرة المعرّفة في قوله :
ولقد أمرّ على اللئيم يسبّني
والحاصل : أنّه يجوز توصيف كلّ نكرة عرّفت بـ «غير»، ولا يجوز توصيف المعرفة الأصليّة كالأعلام به.
أقول : وهذا الجواب لا يخلو من تكلّف، والأحسن ما قاله السرّاج وتبعه الأكثر، وهو أنّ العلّة في عدم كسب «الغير» للتعريف عند الإضافة إنّما هي للتوغّل في الإبهام وتكثير العموم ؛ إذ قولك «مررت بغيرك» يشمل كلّ ما سوى المخاطب من أصناف المخلوقات ؛ إذ الأغيار كثيرة، فالإبهام يزيد
بذلك ولا يتعيّن «الغير» فلا يعرّف، لكن إذا أزيل الإبهام وقلّ العموم فالاشتراك يتعرّف قطعا ؛ إذ العلّة في عدم الكسب المذكور مفقودة هنا.
وتفصيل ذلك : إنّ «الغير» إذا أضيفت إلى شيء لم يكن له إلّا ضدّ واحد، فاريد من ذلك نفي الضدّ وإثبات الشيء يعرّف بالإضافة كما في قولك الحركة غير السكون ؛ إذ ضدّ السكون هو الحركة فقط لا غيرها، فاكتسب التعريف، فيجوز أن يقال «غير المغضوب» صفة «للّذين» إذ «غير المغضوب عليهم» هم الّذين أنعم الله عليهم و «المغضوب عليهم» ضدّ «للّذين» إلى آخره، وليس له ضدّ آخر، فليتأمّل.
وقد قرئ «غير المغضوب» بالنصب على كونه حالا لـ «عليهم» أو مفعولا لـ «أمدح» أو «أعني» أو على انقطاع الاستثناء.
وقوله( وَلَا الضَّالِّينَ ) عطف على ما سبق، و «لا» بمعنى «غير» على ما قاله الكوفيّون، ويؤيّده قراءة عليّ عليه السلام «غير الضالّين» وقيل : «لا» زائدة. فتأمّل.
المقالة الثانية : في معنى الفقرة
فنقول : المراد بقوله( أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ) هم النبيّون والصالحون والشهداء والصدّيقون، ويؤيّده قوله تعالى :( وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَداءِ وَالصَّالِحِينَ ) (١) إلى آخره، والمراد من( الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ) هم اليهود لقوله تعالى :( مَنْ لَعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ
__________________
(١) النساء : ٦٩.
عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنازِيرَ ) (١) إلى آخرها، والمراد من( الضَّالِّينَ ) هم النصارى لقوله تعالى :( وَلا تَتَّبِعُوا أَهْواءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ ) (٢) .
وقيل : المراد بـ «المغضوب عليهم والضالّين» جميع الكفّار من جميع الفرق من دون تخصيص بطائفة دون اخرى، وكذلك المراد من قوله «الّذين أنعمت عليهم» كذلك جميع المؤمنين بالكتب السماويّة، واختار ذلك الجرجانيّ على ما نقل عنه الطبرسيّ رحمه الله ؛ حيث قال : حقّ اللفظ فيه أن يخرج مخرج الجنس، كما تقول نعوذ بالله أن يكون حالنا حال المغضوب عليهم، فإنّك لا تقصد بذلك قوما بأعيانهم قد اختصّوا بذلك.
والحمد لله أوّلا وآخرا. قد فرغ من تأليفه مؤلّفه قبل زمان بلوغه.
__________________
(١) المائدة : ٦٠.
(٢) المائدة : ٧٧.
تفسير
سورة الفتح
بسم الله الرّحمن الرّحيم
[المقدّمة]
مصلّيا على فاتحة كتاب الوجود، وخاتمة دائرة الموجود، صاحب المقام المحمود، الّذي فتح الله له أبواب خزائن الجود بإفاضة الوجود، وعلى آله شموس أفلاك الولاية، وأنوار أقمار الهداية، المخصوصين بأعلى مراتب الكشف والشهود، صلاة دائمة إلى اليوم الموعود.
أمّا بعد، فيقول الفقير إلى رحمة الله ؛ ابن علي مدد حبيب الله : إنّ العقول والبصائر وإن كلّت عن درك أسرار القرآن، والأفكار والأنظار وإن انحسرت في مشاهدة أنوار الفرقان، إلّا أنّ الله عزّ وجلّ قد جعل لكلّ عبد أخلص(١) قلبه للإيمان حظّا من البصائر، وإلهاما في الخاطر، ينكشف له بذلك بعض معضلات القرآن من عباراته، وتنحلّ نبذة من الغوامض بإشاراته، وقد سنح لهذا العبد القاصر عند تفسيري لسورة «الفتح» سوانح، ولاح لي بعون الملك القادر لوائح، ولا بأس بكشف القناع عن بعض وجوه هذه السوانح، وتوضيح رموز بعض هذه اللوائح، مع انكساف البال، واختلال الحال، وعلى الله التكلان في جميع الأحوال.
__________________
(١) «أ» : اختصّ.
( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) قد برهنّا في «زبرنا الفقهيّة» أنّ البسملة من السورة، وبيّنّا تفسيرها في تفسيرنا لسورة الفاتحة.
( إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً ) الفتح والإفتاح والتفتيح والافتتاح في الأصل هو ضدّ الإغلاق، وإلى هذا الأصل يؤول جميع ما ذكروه من المعاني ؛ كالعلم، والحكم، والبسط، والنصر، والقهر، والتيسير(١) ، وبكلّ فسّرت الآية، وإن احتيج في بعضها إلى تقدير اللام مبنيّة للمفعول بتقدير الإرادة ونحوها، ولكن الّذي أحتمله وظنّي أنّه لم يسبقني إليه أحد أنّ المراد به هو فتح أبواب خزائن الجود ؛ أعني إفاضة الوجود على المهيّات الإمكانيّة الّتي في أنفسها أعدام، بإخراجها من الغيب إلى عرصة الشهود، فإنّ أبواب الوجود كانت مغلقة عليها مع ملاحظتها من حيث «هي هي» فإنّها من هذه الحيثيّة ما شمّت رائحة من الوجود.
واللام إشارة إلى أنّ مدخولها وهو الحقيقة المقدّسة المحمّديّة كانت علّة غائيّة للإيجاد، كما قال :خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي . وقال :لولاك لما خلقت الأفلاك (٢) . أو فتح أبواب المعرفة بالآثار والصفات الفعليّة المشار إليها بقوله عزّ وجلّ :كنت كنزا مخفيّا فخلقت الخلق لكي أعرف (٣) . إذ ليس المراد بهذه المعرفة معرفة الذات، فإنّ الحقّ لا يعرفه إلّا الحقّ، فأبواب معرفة الذات مسدودة على غير أهله.
__________________
(١) «أ» : التيسّر.
(٢) بحار الأنوار ١٥ : ٢٨.
(٣) جاء في بيان العلّامة : «كما قال سبحانه : كنت ...» إلى آخره. بحار الأنوار ٨٧ : ١٩٩.
كيف الوصول إلى سعاد ودونها |
قلل الجبال ودونهنّ حتوف |
|
والرجل حافية ومالي مركب |
والكفّ صفر والطريق مخوف |
و «اللام» إشارة إلى أنّ الغرض من هذا الفتح هو معرفة الحقيقة المحمّديّة لكونها مظهرا لصفات الله العليا، ومرآة لأسمائه الحسنى، ووجهه الّذي لا يهلك ولا يفنى، كما قال :( كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ) (١) .
وقال :( كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ * وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ ) (٢) .
وفي الحديث : لولانا ما عرف الله(٣) .
وقال صلّى الله عليه وآله : من رآني فقد رأى الله(٤) .
وقال عليه السلام : إنّ معرفتي بالنورانيّة معرفة الله(٥) .
ومن المحتمل أن تكون «اللام» في مقام الباء، فتكون إشارة إلى أنّه صلّى الله عليه وآله فاتحة الكتاب التكوينيّ ؛ كما أنّ سورة الحمد فاتحة الكتاب التدوينيّ، فهو المتجلّي الأوّل، والعقل الأوّل، وقد قال صلّى الله عليه وآله : أوّل ما خلق الله نوري(٦) . ولا ينافي ذلك ما ورد من أنّ أوّل ما خلق الله اللوح، أو القلم، أو الماء، أو الدرّة البيضاء، أو غير ذلك، فإنّ كلّا منها حكاية عن شأنه الخاصّ، ومقامه المخصوص، فالاختلاف على حسب اختلاف الاعتبارات والحيثيّات :
__________________
(١) القصص : ٨٨.
(٢) الرحمن : ٢٦ و ٢٧.
(٣) بحار الأنوار ٢٥ : ٤.
(٤) بحار الأنوار ٦١ : ٢٣٥. جاء هذا الحديث في بيان العلّامة، وفيه بدل لفظة «الله» لفظة «الحقّ».
(٥) بحار الأنوار ٢٦ : ١. في حديث طويل، ليس فيه لفظة «إن».
(٦) بحار الأنوار ٥٧ : ١٧٠.
عباراتنا شتّى وحسنك واحد |
وكلّ إلى ذاك الجمال يشير(١) |
ووصف «الفتح بالمبين» إشارة إلى أنّ الوجود والمعرفة هما حقيقة النور وجوهره، فإنّه عبارة عن الظاهر بنفسه، المظهر لغيره وإن اختلفت مراتبه بالضعف والقوّة، فإنّ ذلك لا يوجب الاختلاف في الجوهر والحقيقة وإن زعمه المشّائيّة.
والافتتاح بكلمة التحقيق(٢) والتأكيد المستعملة في مقام الترديد والإنكار، دفع لما توهّمه المحرومون عن مشاهدة أنوار لوامع الأسرار ؛ من كونه كسائر من أخلد إلى أرض الناسوت، ولم يصعد إلى سماء الجبروت لقوله :( إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ) (٣) ولم يعرفوا أنّه حكى بذلك هيكل بشريّته، ومقام ناسوتيّته، وإلّا فهو الاسم الأعظم، والتجلّي المعظّم، وسرّ الله المخزون، وغيبه المكنون، جلّ جلاله، وتشعشع جماله :
بلغ العلى بكماله |
كشف الدجى بجماله(٤) |
ولقد منّ الله عليه صلّى الله عليه وآله بهذه المرتبة العليّة السنيّة ؛ الّتي هي أعلى المراتب الإمكانيّة ؛ الّتي لا يفوقها فائق، ولا يدركها لاحق، ولا يطمعها طامع، ولا يطيق استماع كنهها سامع، فقال :( إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً ) وقد روي أنّه لمـــّـا نزلت هذه الآية قال صلّى الله عليه وآله : لقد أنزلت عليّ آية هي
__________________
(١) جامع الأسرار ومنبع الأنوار : ٧٥ نقلا عن : التعليقة على الفوائد الرضويّة : ٨٦.
(٢) مراده كلمة «إنّا».
(٣) الكهف : ١١٠.
(٤) كلّيّات السعديّ، كتاب گلستان : ٢٩.
أحبّ إليّ من الدنيا كلّها(١) . أفترى أنّ ابتهاجه بهذه الآية كان لوعده بفتح مكّة، أو بما اتّفق له في تلك السنة من فتح خيبر وفدك، أو لصلح الحديبيّة، أو لفتح الروم ـ على اختلاف التفاسير الّتي ذكرت في كتبها ـ؟ كيف ولا تعدل الدنيا وزخرفها وإقبالها ودولتها وسلطنتها وفتح بلادها من المشرق والمغرب عنده صلّى الله عليه وآله مقدار جناح البعوضة وما دونها؟ أللّهمّ إلّا أن يكون في ذلك إعلاء لكلمة الإسلام ؛ الكاشفة عن شأنه ورتبته المخصوصة به من بين الأنام.
فيحتمل أن يراد بـ «الفتح المبين» ما نطقت به ألسنة القشريّين من المفسّرين، لكونه كاشفا عن فضله على اليقين للعوامّ دون الخصّيصين من أرباب الشهود، الواقفين على سرّ الوجود، فإنّهم ما عرفوه بشؤون الناسوت ؛ بل شاهدوه بعين الملكوت، أنّه الفارع(٢) من حضيض الإمكان إلى أوج قرب الحيّ الّذي لا يموت ؛ حتّى دنى فتدلّى، فكان قاب قوسين أو أدنى(٣) .
( لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ ) التفات من التكلّم إلى الغيبة، وتعبير على خلاف ما يقتضيه ظاهر سوق الكلام، وانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر غير ما يترقّبه المخاطب، تطرئة لنشاطه، وإيقاظا في إصغائه، وهذا لاشتماله على النكتة الّتي هي من خواصّ التركيب من فنون المعاني، ولكونه من إيراد المعنى الواحد على طرق مختلفة في الوضوح من فنون البيان، ولكونه موجبا لتحسين الكلام وتزيينه من علم البديع ؛ كما صرّح به
__________________
(١) مجمع البيان ٩ : ١٤٠.
(٢) «ب» : العارج.
(٣) إشارة إلى الآية ٩ من سورة النجم.
بعض الأفاضل، وكلمات الفصحاء والبلغاء مشحونة به، والنكتة الّتي أشرنا إليها عامّة لجميع موارده، ولكن قد يختصّ كلّ مورد منها بلطيفة خاصّة به سوى هذا الوجه العامّ على حسب مناسبة المقام.
ولعلّ الوجه فيه في الآية، مضافا إلى صحّة إدراج لفظة الجلالة الّتي هي الاسم الأعظم الجامع لجميع الأسماء ؛ المحتوي على جميع خواصّها المناسبة لرتبة المخاطب ؛ الجامع لجميع كمالات الأنبياء ؛ المخصوص بمظهريّة جميع الصفات والأسماء، المسمّى باسم «عبد الله» في اصطلاح الأولياء، أنّ العبد لا يصدر عنه الذنب إلّا وهو غائب بزعمه عن الله، فإنّ الغفلة عن الشيء وعدم الالتفات عنه بمنزلة الغيبة عنه ؛ وإن كان حاضرا شاهدا، فلا يمكن صدور الذنب عن العبد المؤمن الموقن بأنّه تعالى يراه إلّا إذا التفت إلى سواه، فاحتجب عن ربّه بمرديات هواه.
ففي الالتفات إشارة أيضا إلى أنّ المذنب كما يلتفت عن الربّ وينصرف بوجهه عنه، كذلك الربّ يلتفت ويصرف وجهه عنه ويعرض عن محاضرته كأنّه غائب عنه ؛ كما قال :( نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ ) (١) ، وقال :( نَنْساكُمْ كَما نَسِيتُمْ ) (٢) حسما لجرأة العبد على مخالفة الربّ، وإلى أنّ العبد لا يغيب عن الله وإن زعم أنّه تعالى يغيب عنه.
ولذا صحّ الخطاب من جهته تعالى إليه، وأنّه يعفو عن ذنبه مع هذا الزعم لكمال رأفته به، وتمام رحمته له، قال عليه السّلام : فلو اطّلع اليوم على ذنبي
__________________
(١) التوبة : ٦٧.
(٢) الجاثية : ٣٤.
غيرك ما فعلته، ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته ؛ لا لأنّك أهون الناظرين إليّ، وأخفّ المطّلعين عليّ، بل لأنّك يا ربّ خير الساترين، وأحكم الحاكمين، وأكرم الأكرمين، ستّار العيوب، غفّار الذنوب، علّام الغيوب، تستر الذنب بكرمك، وتؤخّر العقوبة بحلمك(١) إلى آخره.
قوله :( لِيَغْفِرَ لَكَ ) متعلّق بـ «فتحنا» وتعليل للفتح، من غفره : إذا ستره، وغفر الله له ذنبه : إذا غطّى عليه وعفا عنه.
و «الذنب» الإثم، وفعل ما لا يحلّ.
فإن قيل : إنّ المعصوم كيف يكون مأثوما حتّى يغفر ذنبه؟
قلت : أما سمعت ما قيل من أنّ «وجودك ذنب لا يقاس به ذنب» فهو مأخوذ من قول الشاعر :
إذا قلت ما أذنبت قالت مجيبة |
حياتك ذنب لا يقاس به ذنب |
فلعلّ المراد من الذنب المنسوب إليه في الآية هو رؤية وجوده الشريف، وعدم الفناء عنه بكلّيّته، فإنّ ذلك وأمثاله يعدّ ذنبا عند المقرّبين، فكم من حسنات للأبرار هي سيّئات للمقرّبين(٢) ، فالالتفات إلى غير الله كالاتّصاف بالنقائص الطبيعيّة البشريّة الّتي لا بدّ منها في عالم الناسوت ذنب يستغفر عنه أصفياء الله. ولذا كان صلّى الله عليه وآله يستغفر ربّه في كلّ يوم سبعين
__________________
(١) فقرة من دعاء أبي حمزة الثماليّ المأثور عن الإمام عليّ بن الحسين عليهما السلام، معروف عند العامّ والخاصّ. راجع : مفاتيح الجنان للشيخ عبّاس القمّي.
(٢) إشارة إلى عبارة معروفة وجدتها في بيان العلّامة، في البحار ٢٥ : ٢٠٥ وهي : حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين.
مرّة(١) ، مع أنّه كان لم يزل يترقّى في كلّ آن عن درجة من العبوديّة إلى درجة فوقها، فيرى الدرجة السابقة نقصا في خضوعه لربّه بالنسبة إلى الدرجة اللاحقة، فيستغفر من ربّه ما فات من مراتب القرب والخضوع في الدرجة السابقة ؛ إذ كلّما زاده الخضوع رأى عظمة ربّه أكثر ممّا رآه قبل ذلك، فيرى من نفسه التقصير في العبوديّة والتعظيم، ألا ترى أنّ المصلّي في ركوعه يذكر الله باسمه العظيم، وفي سجوده باسمه الأعلى؟
ف «ما تقدّم من ذنبه» كناية عن الأطوار السابقة وما تأخّر عن الدرجات اللاحقة قبل أن ينتهي إلى ما أراد منه من أعلى مدارج القرب، وأرفع معارج الوصول إلى حضرة الربّ.
ومن المحتمل أن يكون الأوّل إشارة إلى وجوده الإبداعيّ، والثاني إلى وجوده التكوينيّ والاختراعيّ، فإنّ فعل الله : إمّا أن يكون مسبوقا بالمدّة والمادّة فيسمّى بالكائن.
وإمّا أن يكون غير مسبوق بشيء منهما وهو المبتدع.
وإمّا أن يكون مسبوقا بالمادّة دون المدّة. والأوّل كالعناصر والعنصريّات، والثاني كالعقول والنفوس المجرّدة، والثالث كالفلك والفلكيّات، فإنّ الزمان من حركة الأفلاك.
ف «النبيّ» الأجلّ الّذي هو آدم الأوّل المخلوق على صورته عزّ وجلّ، قد طوى من أوّل ما أبدعه جميع مراحل الوجود ؛ سوى مرحلة الأحديّة الذاتيّة إلى أن شعشع نوره آفاق عالم الشهود، فإنّ مراحل الوجود ـ على ما حقّقه العارفون ـ خمس :
__________________
(١) إشارة إلى ما ورد في البحار ٢٥ : ٢١٠ من : إنّي لأستغفر الله في كلّ يوم سبعين مرّة.
الأولى : مرتبة الأحديّة الذاتيّة الّتي لا فيها اسم، ولا رسم، ولا صفة، وفيها كان الله ولم يكن معه شيء، والآن كما كان. وهذه مرحلة الوجوب الذاتيّ، لم يصل ولا يصل ولن يصل إليها شيء من مبدعاته وكائناته ومخترعاته، وهو مقام الهويّة المطلقة، وفيه اتّحدت الذات والأسماء والصفات ؛ كما قال عليه السلام : كمال التوحيد نفي الصفات عنه(١) . ويسمّى هذا المقام باللاهوت، وقد سدّ بابه على كلّ شيء دونه، وهو غيب الغيوب، ومقام الأحديّة المحضة، والسرّ المستسرّ، فلا سبيل لغيره إلى معرفته، كما قال : ما عرفناك حقّ معرفتك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك(٢) .
الثانية : مرتبة الأحديّة الجمعيّة ؛ أي الجامعة لجميع الأسماء والصفات على وجه الإجمال ؛ نظير جامعيّة كلمة الجلالة لسائر الأسماء الإلهيّة، ونظير الأصل للفروع والبذر للثمار. وهذه مرتبة الصادر الأوّل الّذي مع كونه بسيط الحقيقة، فيه كلّ شيء «كلّ شيء فيه معنى كلّ شيء».
فتفطّن واصرف الذهن إليّ، وهو العقل الأوّل، وآدم الأوّل، وامّ الكتاب الّذي جميع الموجودات آياته الّتي فصّلت من لدن حكيم خبير، وهو العالم الأوّل، فإنّ العالم في اللغة اسم لما يعلم به كالخاتم لما يختم به، فلا ينبغي
__________________
(١) إشارة إلى كلام أمير الكلام عليه السلام في نهج البلاغة : الخطبة الأولى : وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه.
(٢) هكذا جاء في البحار ٧١ : ٢٣ : قال سيّد العابدين والعارفين والشاكرين صلّى الله عليه وآله : لا أحصي ثناء عليك، أنت ما أثنيت على نفسك، وقال صلّى الله عليه وآله : ما عبدناك حقّ عبادتك، وما عرفناك حقّ معرفتك.
إطلاقه على مرتبة الأحديّة الذاتيّة، فإنّها ممّا لا يعلم به. ولذا قالوا : إنّ العالم هو ما سوى الله. فهذه المرتبة لكونها من فعل الله، سوى الله، وهو ممّا يمكن أن يعلم به، ولمّا لم يسبق بغير الله فيكون عالما أوّلا، ممكنا ذاتيّا لا واجبا كذلك، وإن كان واجبا بالغير وقديما بالنسبة إلى ما دونه، حادثا بالإضافة إلى ما فوقه، وتسمّى هذه المرتبة بالحقيقة المحمّديّة، فإنّها الجامعة لجميع الأسماء الحسنى، والحاكية لجميع الصفات العليا، ولذا ظهرت منها وبها ولها جميع الموجودات من المبدعات والكائنات والمخترعات ؛ كما قال : أنا من الله والمؤمنون منّي. وحديث شجرة اليقين المذكور في بعض الكتب كناية عن هذه المرتبة، ورمز إلى هذا المقام، ولمّا كانت هذه الحقيقة المقدّسة أوّل حاك عن الأسماء والصفات كانت نبوّة محمّد صلّى الله عليه وآله أصليّة، فإنّ معنى النبيّ هو المخبر المنبئ عن الله فكان هو أوّل النبيّين كما قال : كنت نبيّا وآدم بين الماء والطين(١) . ولمّا كانت نبوّته أصليّة لم ينصرم دونه(٢) إلى آخر الدهر [بخلاف](٣) كما في سائر النبوّات، فإنّها منصرمة، فهو آخر النبيّين وخاتمهم.
الثالثة : مرتبة الواحديّة الجمعيّة وهي مرتبة ظهور الأسماء والصفات وتعيّنها وتميّزها وبروز كلّ عن مكمن الغيب إلى الشهود على وجه خاصّ بالفيض المقدّس ؛ كما أنّ استفاضة المرتبة الثانية كانت بالفيض الأقدس،
__________________
(١) بحار الأنوار ١٦ : ٤٠٢.
(٢) «أ» : وقته.
(٣) «أ» : كما في.
وتسمّى هذه المرتبة بـ «عالم الجبروت» مبالغة من الجبر.
قال الغزاليّ في كتابه المسمّى بـ «كشف الوجوه» : والجبر إمّا بمعنى الإجبار ؛ من قولهم : جبرته على الأمر جبرا، وأجبرته : أكرهته، أو بمعنى الاستعلاء ؛ من قولهم : نخلة جبّارة : إذا فاقت الأيدي، والجبّار : الملك تعالى كبرياؤه، متفرّد بالجبروت، لأنّه يجري الأمور مجاري أحكامه، ويجبر الخلق على مقتضيات إلزامه، أو لأنّه يستعلي عن درك العقول.
الرابعة : مرتبة الأرواح وتسمّى بـ «عالم الملكوت» مبالغة من الملك ؛ وهو التصرّف في الأشياء بالاستعلاء. وروي أنّه خلق الأرواح قبل الأجساد بأربعة آلاف سنة(١) .
الخامسة : مرتبة الشهادة المطلقة وتسمّى بـ «عالم الملك، والناسوت، والأجسام، والعنصريّات، والطبيعيّات» ولتفصيل هذه المراحل محلّ آخر.
والغرض من ذكرها : أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله كان سائرا في المراحل الإمكانيّة إلى مرحلة الشهادة، وكان له في كلّ منها وجود خاصّ، فالتفاته إلى هذا الوجود ذنب ؛ لكونه التفاتا إلى غير الله بحسب الظاهر.
وبعبارة أخرى : كان له وجه إلى الحقّ ووجه إلى الخلق لكونه واسطة بينهما، فوجهه إلى الخلق يعدّ ذنبا متقدّما ومتأخّرا على التفصيل الّذي عرفته، ومثل هذا الذنب لا ينافي العصمة المشترطة(٢) في الأنبياء والمقرّبين ؛ بل هو في الحقيقة ليس ذنبا ؛ إذ هو ممّا لا بدّ منه في إرشاد العباد، ونظم
__________________
(١) جاء في البحار ٦١ : ١٣٦ : إنّ الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام.
(٢) «أ» : المشروطة.
المعاش والمعاد، وإنّما أطلق عليه اسم الذنب لاعتذارهم عنه في مقام المناجاة ؛ إظهارا للتقصير في مقام العبوديّة لغاية التذلّل والتخشّع ؛ كما هو شأن العبد الذليل، في حضرة الملك الجليل، وقد يذكر لدفع هذه الشبهة وجوه اخر :
منها : أنّ الذنب مصدر مضاف إلى مفعوله دون فاعله ؛ أي لذنبهم إليك قديما بأذاهم لك في بدو البعثة وقبل الهجرة، وحديثا بمنعهم لك عن دخول مكّة للحجّ، وذلك بسبب دخول كثير منهم في الإسلام بسبب هذا الفتح الّذي صار سببا لشوكتك وعزّتك، أو لزوال وصمة ما صنعوا بك من الإهانة والإذلال في المنع عن الدخول وغيره. فالمراد بالمغفرة على هذا : إزالة الوصمة والعار دون العفو عمّا صدر عنه بالاختيار، فقد حصل الانجبار لهذا الانكسار، بنصرة العزيز الجبّار.
ومنها : أنّه صلّى الله عليه وآله لمـــّـا أظهر نبوّته وأمر المشركين بالتوحيد ونهاهم عن عبادة ثلاثمائة وستّين صنما، كبر ذلك عليهم وقالوا :( أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً ) (١) ، فنسبوه إلى الكذب والذنب، فلمّا وقع له هذا الفتح علموا أنّه كان صادقا يدعو من عند الله ؛ حيث أظهره عليهم، وكسر أصنامهم، وأذلّ رؤساءهم من عبدة الأصنام. وقد ورد حديث عن الرضا عليه السّلام قريبا من هذا الوجه، فالمراد بالمغفرة إزالة الوصمة باعتقادهم.
ومنها : أنّه من قبيل «إيّاك أعني واسمعي يا جاره» لما ورد من أنّ القرآن
__________________
(١) الشورى : ٥.
نزل على ذلك(١) ، فالمخاطب وإن كان [النبيّ صلّى الله عليه وآله] بحسب الظاهر إلّا أنّ المقصود منه هو الامّة لاتّصالهم به، وانتسابهم إليه صلّى الله عليه وآله، فجهادهم للمشركين وانتصارهم له صلّى الله عليه وآله في هذا الفتح صار سببا لمغفرة ذنوبهم الّتي صدرت عنهم قبل الفتح أو بعده.
وعلى هذا فالتجوّز إمّا في الإسناد، لكفاية أدنى الملابسة في الإضافة، أو في الكلمة، لعلاقة المجاورة ونحوها. وكذا الكلام في الضمير المجرور باللام، ولكنّ إبقاءه على ظاهره أولى، فيكون المعنى : أنّ هذه المغفرة لهم كانت لأجلك ولحرمتك وشأنك، لكونهم رعيّتك المتديّنين بدينك، أو لشفاعتك(٢) لهم في الدنيا والآخرة.
ثمّ المراد بالامّة المغفورة المرحومة هم الامّة الإجابتيّة خاصّة، وهم الّذين أجابوا دعوته، واتّبعوا دينه، وماتوا على ملّته الحنفيّة، وإلّا فجميع من عاصره مذ دعا إلى توحيد الله إلى يوم القيامة كانوا من امّته وإن كانوا من اليهود أو النصارى أو غيرهم من أهل الملل وغيرهم، بل قد يقال في تفسير الآية(
لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ
)
من آدم إلى زمانك،
(
وَما تَأَخَّرَ
)
من زمانك إلى يوم القيامة، فإنّ الكلّ أمّته، فإنّه ما من امّة إلّا وهي تحت شرع محمّد صلّى الله عليه وآله من اسم الباطن من حيث «كان نبيّا وآدم بين الماء والطين»(٣)
فدعا الكلّ إلى الله، فالكلّ أمّته من آدم إلى يوم القيامة، فبشّره الله
__________________
(١) جاء في البحار ٩٢ : ٣٨٢ : عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : نزل القرآن بـ «إيّاك أعني واسمعي يا جاره».
(٢) «أ» : بشفاعتك.
(٣) بحار الأنوار ١٨ : ٢٧٨.
بالمغفرة لما تقدّم من ذنوب الناس وما تأخّر منها، وكان هو المخاطب، والمقصود : الناس، فيغفر الكلّ ويعدهم، وهو اللائق لعموم رحمته الّتي وسعت كلّ شيء(١) ، ولعموم مرتبة محمّد صلّى الله عليه وآله حيث بعث إلى الناس كافّة بالنصّ ولم يقل : أرسلناك إلى هذه الامّة خاصّة(٢) .
أقول : والسرّ في ذلك كلّه وتوضيحه ما ذكره الغزاليّ في شرح قصيدة ابن فارض المصريّ من أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله هو المنبئ عن ذات الله وصفاته وأسمائه وأحكامه ومراداته، والإنباء الحقيقيّ الذاتيّ الأوفى ليس إلّا للروح الأعظم الّذي بعثه الله إلى النفس الكلّيّة أوّلا، ثمّ إلى النفوس الجزئيّة ثانيا، لينبّئهم بلسانه العقليّ عن الذات الآخريّة، والصفات الأزليّة، والأسماء الإلهيّة، والأحكام القديمة، والمرادات الجسميّة ـ إلى أن قال ـ وكلّ نبيّ من آدم إلى محمّد صلّى الله عليه وآله مظهر من مظاهر نبوّة الروح الأعظم، فنبوّته دائمة ونبوّة المظاهر عرضيّة ومنصرمة، إلّا نبوّة محمّد صلّى الله عليه وآله فإنّها دائمة غير منصرمة ؛ إذ حقيقته حقيقة الروح الأعظم، وصورته المصوّرة(٣) الّتي ظهر فيها الحقيقة بجميع أسمائها وصفاتها، وسائر الأنبياء مظاهرها ببعض الأسماء والصفات، تجلّت في كلّ مظهر بصفة من صفاتها، واسم من أسمائها، إلى أن تجلّت في المظهر المحمّديّ بذاتها وجميع صفاتها، وختم به النبوّة، فكان الرسول صلّى الله عليه وآله سابقا على جميع
__________________
(١) إشارة إلى الآية ١٥٦ من سورة الأعراف :( قالَ عَذابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ) .
(٢) إشارة إلى الآية ٢٨ من سورة سبأ :( وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً ) .
(٣) «أ» : الصورة.
الأنبياء من حيث الحقيقة، متأخّرا عنهم من حيث الصورة ؛ كما قال : نحن الآخرون السابقون(١) .
وقال : وكنت نبيّا وآدم بين الماء والطين(٢) .
وفي رواية : بين الروح والجسد(٣) . أو لا روحا ولا جسدا ـ إلى أن قال ـ : وأضرب لك مثلا : دائرة، لها وجود في الذهن، ووجود في الخارج، وهو مظهر للوجود الذهنيّ وصورته، والذهنيّ حقيقيته ومعناه متقدّم عليه، ووجودها الخارجيّ خطّ مستدير متألّف من نقط متواصلة، ووجود كلّ نقطة منها مظهر وصف من أوصاف وجودها الذهنيّ، ولا توجد حقيقتها في الخارج إلّا عند تكامل الأجزاء وتواصلها بوجود النقطة الأخيرة المتّصلة بالنقطة الأولى، فالنقطة الأخيرة لاشتمالها على سائر النقط مظهر لحقيقة الدائرة، وسائر النقط مظاهر أوصافها.
فكذلك مثل النبوّة، دائرة لها وجود في الغيب هو حقيقتها ومعناها، ووجود في الشهادة هو مظهرها وصورتها، والحقيقة متقدّمة على الصورة من حيث الوجود، متأخّرة عنها من حيث الظهور، ووجودها الخارجيّ خطّ مستدير متألّف من نقط وجودات الأنبياء المتواصلة، ووجود كلّ نقطة منها مظهر صفة من أوصافها في الوجود العينيّ، ولا توجد في الخارج إلّا عند تكامل أجزائها من النقط بوجود النقطة الأخيرة الّتي هي الصورة الجزئيّة
__________________
(١) بحار الأنوار ٦١ : ٢٣٢.
(٢) بحار الأنوار ١٦ : ٤٠٢، عوالي اللئالي ٤ : ١٢١، مفتاح الفلاح : ٤١، المناقب ١ : ٢١٤.
(٣) بحار الأنوار ١٨ : ٢٧٨.
المحمّديّة صلّى الله عليه وآله وتمّ بها صورة دائرة النبوّة، وظهر منها حقيقتها بجميع أوصافها.
وحقيقة هذه الدائرة هي الروح الأعظم الّذي هو حامل معنى النبوّة، وله بداية وهي أوّل نقطة الأنبياء وهو وجود آدم عليه السلام وحركة دوريّة في نقط وجودات الأنبياء ونهاية منطبقة على البداية وهو النقطة الأخيرة المحمّديّة ـ إلى أن قال ـ :
فظهر من ضرب هذا المثل : أنّ نبوّة الرسول صلّى الله عليه وآله ذاتيّة دائمة، لأنّها المنتهى، ومنتهى الدائرة عين المبدأ، ومبدأ النبوّة هو الروح الأعظم المتجلّي في كلّ نقطة من نقط الأنبياء بوصف من أوصافها [وفي نقطة الصورة المحمّديّة بذاتها كظهور البذرة في كلّ مرتبة من مراتب النموّ بوصف من أوصافها](١) وفي منتهى المراتب وهي الثمرة بالذات إلى آخر ما ذكره. فافهم.
وإلى هذا الوجه يرجع ما روي عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : ما كان له ذنب ولكنّ الله ضمن له أن يغفر ذنوب شيعة عليّ عليه السّلام ما تقدّم من ذنبهم وما تأخّر(٢) .
فإنّ الامّة المرحومة الفائزين بالرحمة الواسعة منحصرة في شيعة عليّ بن أبي طالب عليه السّلام كما يستفاد من الأخبار المتواترة، فلا يدخل الجنّة إلّا من كان محبّا له من زمن آدم إلى يوم القيامة، ولا يخلد في النار إلّا من كان مبغضا له كذلك.
__________________
(١) ليست في «أ».
(٢) بحار الأنوار ٧١ : ٢٤.
وفي رواية المفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : بما صار عليّ بن أبي طالب قسيم الجنّة والنار؟
قال : لأنّ حبّه إيمان، وبغضه كفر، وإنّما خلقت الجنّة لأهل الإيمان، وخلقت النار لأهل الكفر، فهو عليه السّلام قسيم الجنّة والنار لهذه العلّة، والجنّة لا يدخلها إلّا أهل محبّته، والنار لا يدخلها إلّا أهل بغضه.
قال المفضّل : يا ابن رسول الله، فالأنبياء والأوصياء هل كانوا يحبّونه وأعداؤهم يبغضونه؟
فقال : نعم.
قلت : فكيف ذلك؟
قال : أما علمت أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله قال(١) يوم خيبر : لأعطينّ الراية غدا رجلا يحبّ الله ورسوله، ويحبّه الله ورسوله، ما يرجع حتّى يفتح الله على يده؟
قلت : بلى.
قال : أما علمت أنّ رسول الله لمـــّـا أوتي بالطائر المشويّ قال : أللّهمّ ائتني بأحبّ خلقك إليّ يأكل معي هذا الطائر وعنى به عليّا عليه السّلام؟ [فدفع الراية إلى عليّ عليه السّلام ففتح الله عزّ وجلّ على يديه]؟
قلت : بلى.
قال : يجوز أن لا يحبّ أنبياء الله ورسوله وأوصياؤهم رجلا يحبّه الله ورسوله؟
__________________
(١) «أ» : بم قال.
فقلت : لا.
قال : فهل يجوز أن يكون المؤمنون من أمّتهم لا يحبّون حبيب الله وحبيب رسوله وأنبيائه؟
قلت : لا.
قال : فقد ثبت أنّ جميع الأنبياء ورسله وجميع المؤمنين كانوا لعليّ بن أبي طالب محبّين، وثبت أنّ المخالفين لهم كانوا له ولجميع أهل محبّته مبغضين.
قلت : نعم.
قال : فلا يدخل الجنّة إلّا من أحبّه من الأوّلين والآخرين، فهو إذن قسيم الجنّة والنار.
إلى أن قال : يا مفضّل، خذ هذا فإنّه من مخزون العلم ومكنونه، لا تخرجه إلّا إلى أهله(١) .
تتمّة : «اللام» في قوله :( لِيَغْفِرَ ) للعلّة، والأصل فيها أن تكون حاصلة قبل المعلول، كما في قولهم «ضربته لسوء أدبه» و «قعدت عن الحرب جبنا» وقول الشاعر :
لا أقعد الجبن عن الهيجاء |
ولو توالت زمر الأعداء |
فعلى تفسير الفتح بما ذكره المفسّرون يكون الفتح سببا للمغفرة دون
__________________
(١) وفي البحار ٣٩ : ١٩٤ ؛ ما يختلف بعباراته، لكن يقرب منه، وكذا : علل الشرائع ١ : ١٦٢، الأمالي، للصدوق : ٤٦، بصائر الدرجات : ١٩٩.
العكس، فخرج(١) الكلام عن مقتضى الأصل في «اللام»، فيكون كقولهم «ضربته للتأديب» أي لتحصيل الأدب له، لا لحصوله سابقا، فيجب التأويل بالإرادة ؛ أي إرادتي لمغفرة ذنبك صارت سببا لأن فتحت لك هذا الفتح.
وحينئذ فنجري «اللام» على الأصل فيها، وأمّا على ما فسّرناه به من فتح باب الوجود فهي على أصلها من دون تكلّف تقدير الإرادة السابقة، فإنّ المراد من المغفرة، الرحمة والمحبّة الإلهيّة المستفادة من قوله : «فأحببت أن أعرف»(٢) ، وقد كانت أزليّة قديمة ؛ كما قال :( وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ ) (٣) ؛ أي للرحمة، فتفطّن(٤) .
هذا مع أنّ الحقّ أنّ المشيّة والإرادة من صفات الفعل لا من صفات الذات، فهما أيضا مخلوقتان ؛ كما قال : «خلق الأشياء بالمشيّة، وخلق المشيّة بنفسها»(٥) ، وقد عرفت أنّ الحقيقة المحمّديّة هي الإبداع الأوّل، فلو كانت مخلوقة بالمشيّة كانت سابقة عليها وأوّل ما خلق، فكيف تكون هذه الحقيقة أوّل ما خلق الله؟! أللّهمّ إلّا أن يقال : إنّ هذه الحقيقة عين المشيّة ؛ كما يستفاد من بعض الروايات. فافهم.
ولك أن تجعل «اللام» للعاقبة، أو العلّة الغائيّة، فيكون مدخولها مسبّبا لا
__________________
(١) «أ» : فيخرج.
(٢) بحار الأنوار ٨٧ : ١٩٩.
(٣) هود : ١١٩.
(٤) بحار الأنوار ٢٤ : ٢٠٦.
(٥) في البحار ٥٧ : ٥٦ عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : خلق الله المشيّة بنفسها، ثمّ خلق الأشياء بالمشيّة وكذا : الكافي ١ : ١١٠.
سببا ؛ كما في قوله تعالى :( لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً ) (١) وقوله : «لدوا للموت وابنوا للخراب»(٢) فيكون المراد بهذا الكلام الإشارة إلى مقام فناء الوجود في صرف الوجود، والفناء عن هذا الفناء الموجب للبقاء بالله الّذي هو آخر مراحل السالكين، وأعلى منازل الواصلين ؛ المشار إليه بقوله عليه السّلام : «العبوديّة جوهرة كنهها الربوبيّة»(٣) لا أقول كما يقوله الملاحدة من الصوفيّة من الوحدة والاتّحاد والحلول، وأنّ القطرة من الوجود تفنى في بحر الوجود، ويتّحد الممكن بالواجب، فيصير إلها واجبا وجوده بذاته أو غير(٤) ذلك من الترّهات الواهية.
بل أقول : إنّ العبد حينئذ يتخلّق بأخلاق الله، ويتّصف من كمال القرب بصفات الله، ويتّسم بأسماء الله، فيصدر عنه أفعاله بإرادة الله، فتفنى إرادته في إرادة الله، فلا يشاء إلّا ما يشاء الله، ولا ينظر إلّا بعين الله، ولا يسمع إلّا بإذن الله، ولا ينطق إلّا بلسان الله ؛ كما قال : العبد يتقرّب إليّ بالنوافل حتّى كنت سمعه(٥) إلى آخره.
وفي مصباح الشريعة : إنّ العارف أمين ودائع الله، وكنز أسراره، ومعدن نوره، ودليل رحمته على خلقه، ومطيّة علومه، وميزان فضله ـ إلى أن قال ـ
__________________
(١) القصص : ٨.
(٢) إنّ لله ملكا ينادي في كلّ يوم لدوا للموت، وابنوا للخراب. نهج البلاغة، الكلمات القصار : ١٣٢ وكذا : الكافي ٢ : ١٣١.
(٣) مصباح الشريعة : ٧.
(٤) «م» : نحو.
(٥) الكافي ٤ : ٥٣ كتاب الإيمان والكفر، باب من آذى المسلمين واحتقرهم.
لا مونس له سواه، ولا نطق ولا إشارة ولا نفس إلّا بالله، ومن الله، ومع الله.
وفيه أيضا : حبّ الله إذا أضاء على سرّ عبد أخلاه عن كلّ شاغل، وكلّ ذكر سوى الله عنده ظلمة(١) إلى آخره.
فإذا وفّق الله عبدا لأن ينسى وجوده الموهوم ويغطّي عليه غطاء الحياء والخوف بحيث لا يرى نفسه في جنب وجود الحقّ الّذي هو حقيقة الوجود وصرفه، فقد غفر له وستر على وجوده الّذي لا ذنب أعظم من رؤيته في جنب وجود الله، وحينئذ يصير فانيا في الله، باقيا ببقاء الله، فيصير منشأ لأفعال الربوبيّة، ومحلّا للقدرة الإلهيّة.
وفي الحديث القدسيّ : يا بن آدم، أطعني فيما أمرتك وانته عمّا نهيتك حتّى أجعلك مثلي وليس كمثلي، أنا إذا أقول لشيء كن! فيكون، وأنت إذا تقول لشيء كن! فيكون(٢) .
وفيه أيضا : [يا ابن آدم،] أنا حيّ لا أموت، أطعني حتّى أجعلك حيّا لا تموت(٣) .
كلّ ذلك في ساحة الإمكان وفيما دون مرحلة اللاهوت، ما للتراب وربّ الأرباب والاتّصاف بالصفات غير الاتّصال بالذات والحديدة المحماة بمجاورة النار من غير سنخ النار مع أنّها تفعل فعل النار. وهذا المثال للتقريب، وإلّا فلا مجال للتمثيل والمثال، وقد أجاد من قال :
__________________
(١) مضباح الشريعة : ١٩٢، جامع الأخبار : ٨١.
(٢) بحار الأنوار ٧١ : ١٣٥.
(٣) بحار الأنوار ٩٣ : ٣٧٢. وليس فيه كلمة «حتّى».
آهنى چه؟ آتشى چه؟ لب ببند |
ريش تشبيه ومشبّه را بخند(١) |
إذا عرفت ما عرّفناك، فلا يغرّنّك كلمات الصوفيّة في هذا المقام، وأشعارهم المبنيّة على الخيالات الشيطانيّة، والزندقات الفرعونيّة، وقد نقلنا جملة منها في كتابنا المسمّى بـ «أسرار العارفين» وفي «شرح العديلة» وغيرهما، فالحمد لله ربّ العالمين.
( وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ ) المصدر(٢) للمضاف وإن عمّ، إلّا أنّه يحتمل أن يكون المراد بالمضاف خصوص نعمة الوجود، لكونها أصل جميع النعم الظاهريّة والباطنيّة وأمّها ؛ إذ ما من نعمة دنيويّة كانت أو أخرويّة إلّا وهي راجعة إلى أمر وجوديّ ؛ كما أنّه ليس شيء من الشرور والنقم إلّا ومرجعه إلى العدم، ولذا ادّعوا الضرورة على أنّ الوجود من حيث أنّه وجود خير محض، والعدم من حيث أنّه عدم شرّ كذلك.
فالمراد بإتمام النعمة إكمال الوجود بوصوله إلى فعليّة ما فيه من القابليّة والاستعداد للمراتب العالية، وقد عرفت أنّ أعلى مراتب العبد : الوصول إلى مقام الفناء عن وجوده باستغراقه في لجّة العبوديّة بحيث لا يشغله شيء سوى ذكر الله، ولا يرى شيئا في الوجود سوى الله.
ومن زعم أنّ الفناء عبارة عن استغراق الوجود الإمكانيّ في لجّة بحر الوجود الوجوبيّ واستتار نور العقل الفارق بين الأشياء في غلبة نور الذات
__________________
(١) وفي المثنوي للمولويّ في معنى «في التأخير آفات» :
آتش چه؟ آهن چه؟ لب ببند |
ريش تشبيه ومشبّه را بخند |
(٢) «أ» : والمصدر.
القديمة وارتفاع التميّز بين القدم والحدوث لزهوق الباطل ؛ أي الوجود الموهوم بمجيء الحقّ ؛ أي صرف الوجود وعروج العبد عن حضيض الناسوت والملكوت والجبروت إلى أوج اللاهوت، وصيرورته صرف الوجود الخاصّ بذات الباري تعالى وانقلاب إمكانه إلى الوجوب، فقد أخطأ وكفر وأنكر شريعة سيّد البشر وادّعى إمكان الممتنع بالذات، وليس له دليل سوى لقلقة اللسان بإنشاد الأبيات.
ومن المحتمل أن يراد بالنعمة النبوّة الّتي هي إخبار عن أسماء الله وصفاته ومراداته وأحكامه، وبإتمامها إدامتها وإبقائها إلى آخر الدهر. وقد عرفت السرّ في أنّ نبوّة هذا الرسول المعظّم لا تجوز أن تنقطع وتنصرم أبدا بخلاف سائر النبوّات.
ويحتمل أن يراد بإتمامها إكمال النبوّة بالولاية الكلّيّة الّتي هي ثمرة شجرة النبوّة ومظهرها وهو عليّ بن أبي طالب عليه السلام كما قال تعالى :( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ) (١) فكما لا فائدة في الشجر ما لم يكن معه ثمر، فكذلك لا يترتّب على ما بلّغه الرسول ما لم يكن معه ولاية الوصيّ، وقد أشير إليه في قوله :( وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ ) (٢) وممّا ذكرنا ينكشف السرّ في قوله : «ولو لا عليّ لما خلقتك»(٣) .
__________________
(١) المائدة : ٣.
(٢) المائدة : ٦٧.
(٣) عن كتاب فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفى من مهدها إلى لحدها ١ : ٩ نقلا عن كشف اللئالى، لصالح بن عبد الوهّاب بن العرندس «عن الله تبارك وتعالى : يا أحمد، لولاك لما خلقت الأفلاك، ولو لا عليّ لما خلقتك، ولو لا فاطمة لما خلقتكما».
ولا يلزم منه كون عليّ عليه السّلام أفضل من محمّد صلّى الله عليه وآله كما توهّمه من لا فطنة له، فإنّ مثل محمّد صلّى الله عليه وآله مثل الشجرة مع الثمرة، ومثل عليّ عليه السّلام مثل الثمرة خاصّة، فكيف يكون الجزء أفضل من الكلّ؟ كيف وقد قال عليّ عليه السّلام : أنا عبد من عبيد محمّد(١) .
وقد يقال : إنّ المراد بإتمام النعمة إعلاء الدين وضمّ الملك إلى النبوّة.
وفي مجمع البيان : معناه ؛ ويتمّ نعمته عليك في الدنيا : بإظهارك على عدوّك، وإعلاء أمرك، ونصرة دينك، وبقاء شرعك، وفي الآخرة : برفع محلّك، فإنّ معنى إتمام النعمة فعل ما يقتضيها ويبقيها على صاحبها والزيادة فيها.
وقيل : يتمّ نعمته عليك بفتح خيبر ومكّة والطائف. انتهى(٢) . فافهم وتأمّل.
( وَيَهْدِيَكَ صِراطاً مُسْتَقِيماً ) إن كان المعنيّ به الامّة أو الشيعة، والمراد بالهداية مطلق إراءة الطريق سواء كانت موصلة إلى المطلوب أو غير موصلة، فلا إشكال. وعدم إجابة الكثير من الناس لا يبطل الغرض من الهداية بعد اهتداء من أراد الله هدايته ؛ كما قال :( وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ) (٣) وقال :( هُدىً [وَبُشْرى] لِلْمُؤْمِنِينَ ) (٤) وقد خاطب الله في كتابه في مواضع منه الّذين آمنوا مع أنّ الكفّار أيضا عندنا مكلّفون بالفروع كتكليفهم بالأصول، وبالأصول عند الجميع.
__________________
(١) بحار الأنوار ٣ : ٢٨٣.
(٢) مجمع البيان، المجلّد ٥ : ١٦٩.
(٣) الذاريات : ٥٥.
(٤) البقرة : ٩٧.
وكذا لو كان المعنيّ بالخطاب هو نفسه الشريفة، وبالهداية ما ذكر، ولكن على تقدير نزع الخافض ؛ أي ويهدي بك الناس الصراط المستقيم، وإطلاق الهداية لاختلاف الناس في الوصول وعدمه وإن قلّ الواصلون.
خليليّ قطّاع الفيافي إلى الحمى |
كثير وأنّ الواصلين قليل |
والقول بأنّ الهداية إذا عدّيت إلى المفعول الثاني بلا واسطة أو بواسطة «إلى» فهي موصلة، وإذا عدّيت بواسطة «اللام» كما في قوله تعالى :( إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ) (١) فهي للإراءة لا دليل عليه.
والمراد بالصراط المستقيم على هذين الوجهين هو الطريق المستوي الّذي لو سلكه والتزمه السالك أفضاه إلى الجنّة سواء كان حسّيّا أو عقليّا، فيدخل فيه جميع ما فسّروه به من الجسر الممدود على جهنّم، ومعرفة الله، والتوحيد، والشريعة، وتهذيب الأخلاق بالرياضات، وولاية الإمام المفترض الطاعة، وحبّ عليّ بن أبي طالب عليه السلام، والتوسّط بين مطلق الإفراط والتفريط، أو خصوص إفراط النصارى وتفريط اليهود ؛ كما أشار إليه بقوله :( لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ ) (٢) وقوله :( غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ) (٣) والصورة الإنسانيّة والتوسّط بين الخوف والرجاء وغير ذلك من المسالك الاعتداليّة، وكلّ منها أدقّ من الشعر، وأحدّ من السيف ؛ كما لا يخفى على من له أدنى بصيرة وفطنة.
__________________
(١) الإسراء : ٩.
(٢) النور : ٣٥.
(٣) الفاتحة : ٧.
ولا يخفى أنّ جميع هذه الحقائق متلازمة في الوجود، وصورتها الّتي تظهر فيها في القيامة الكبرى هو الجسر الممدود الّذي لا يمكن لأحد من الناس أن لا يمرّ عليه، ولا يمكن لأحد منهم الوصول إلى الجنّة إلّا بالمرور عليه، إلّا أنّ منهم من يمرّ عليه مثل البرق، ومنهم من يمرّ عليه كعدو الفرس، ومنهم من يمرّ عليه ماشيا، ومنهم من يمرّ عليه حبوا، ومنهم من يمرّ عليه متعلّقا فتأخذ منه النار شيئا، ومنهم من يسقط فيها في قدمه الاولى، فقد قال تعالى :( وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا ) (١) .
وهذا الاختلاف إنّما نشأ من اختلافهم في المعرفة والسلوك في الدار الدنيا، وقد ورد أنّ الصراط مظلم يسعى الناس على قدر أنوارهم :( أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلى وَجْهِهِ أَهْدى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ) (٢) .
وفي تنكير «الصراط» إشارة إلى أنّ لكلّ طريقا خاصّا إلى الحقّ على حسب ما أعطاه الله من القابليّة والاستعداد، فإنّ «الطّرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق»(٣) ، كما روي في بعض الكتب، فلا يطلب من الأدنى ما يؤاخذ عليه الأعلى ؛ إذ لا يكلّف الله نفسا إلّا ما آتاها، ولا يكلّفها إلّا وسعها وبقدر طاقتها، قال الله تعالى :( أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها ) إلى قوله( كَذلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ ) (٤) .
وقد فسّر «الماء» بالعلم، و «الأودية» بالقلوب، فكلّ مكلّف في السلوك
__________________
(١) مريم : ٧١.
(٢) الملك : ٢٢.
(٣) بحار الأنوار ٦٧ : ١٣٧.
(٤) الرعد : ١٧.
على حسب فهمه وقدرته، فيحصل لكلّ مع سلوكه على ما يطيقه وعلى حسب ما يتيسّر له من الإدراك صراط يوصله إلى الجنّة غير صراط الآخر، وكلّ مستقيم بالنسبة إلى سالكه وبحسبه إذا أدّى حقّ سلوكه، لا أقول كما يقوله بعض المتصوّفة من أنّ مآل سلوك كلّ أحد إلى الجنّة ؛ وإن ذهب إلى ما ذهب من المذاهب الفاسدة، حتّى عابد الوثن وعابد صنمي قريش وجبتيها، كيف وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ستفترق امّتي على بضع وسبعين فرقة كلّهم في النار إلّا من اتّبع عليّ بن أبي طالب(١) .
وقال الله :( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ ) (٢) .
وقال :( وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) (٣) . وغير ذلك ممّا لا يحصى من الأخبار والآيات.
وجميع ما ذهب فيه أرباب المذاهب الباطلة وإن كان صراطا إلّا أنّه ليس مستقيما، والسلوك في غير المستقيم ضلالة لا هداية، فكما أنّ المستقيم من الصراط موصل إلى النعيم كذلك غيره موصل إلى الجحيم، والمستقيم لا يكون إلّا واحدا وهو أدقّ من الشعر كالخطّ الهندسيّ الفاصل بين نور الشمس وظلّه، فإنّه لدقّته لا يعدّ من النور ولا من الظلّ، وكما لا يكون للدائرة إلّا مركز واحد وهو النقطة الواحدة في وسطها، كذلك لا يكون الحقّ إلّا واحدا.
__________________
(١) في البحار ٢٨ : ٣٠ ؛ حديث قريب منه.
(٢) آل عمران : ١٩.
(٣) آل عمران : ١٠٢.
وكما لا يكون ما بين حدّي الخطّ المستقيم إلّا خطّ واحد مستقيم وإن تعدّدت الخطوط الغير المستقيمة كذلك صراط الحقّ لا يكون إلّا واحدا مستقيما وهو «صراط الّذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالّين».
فإنّ صراطهم إمّا على جهة الإفراط، أو على جهة التفريط ؛ بخلاف صراط المنعم عليهم، فإنّ صراطهم في الوسط المستوي على الخطّ المستقيم الّذي يصل المارّ عليه إلى جنّة النعيم.
وكذا إن كان المعنيّ بالخطاب هو نفسه المقدّسة ولكن بتقدير الخافض كلمة «إلى» ؛ أي ليهدي إليك قومك ؛ كما فسّر به قوله :( وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدى ) (١) ، قال الرضا عليه السّلام : وضالّا في قوم لا يعرفون فضلك فهداهم إليك(٢) .
وحينئذ فـ «صراطا مستقيما» حال من «الكاف» ففيه دلالة صريحة على أنّه صلّى الله عليه وآله هو الصراط المستقيم ؛ إذ المتّبع له، الملتزم لطريقته وسنّته يصل البتّة إلى الجنّة، والمتخلّف عنه المنحرف عن شريعته يصلى الجحيم قطعا، وقد قال الله له صلّى الله عليه وآله :( فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ ) (٣) وحيث كانت أخلاقه معتدلة وأحواله كلّها اعتداليّة كان هو الصراط المستقيم، كما أنّ شريعته الجامعة أيضا كذلك ؛ كما قال :( وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ) (٤) .
__________________
(١) الضحى : ٧.
(٢) بحار الأنوار ١٦ : ١٣٩.
(٣) هود : ١١٢.
(٤) المؤمنون : ٧٣.
وقال :( فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ) (١) .
ولا ينافي ذلك قوله :( وَأَنِ اعْبُدُونِي هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ ) (٢) وقوله :( فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ ) (٣) فإنّ العبادة لا تكون إلّا من حيث أمر الله، وقد أمر عباده أن يعبدوه بدلالة أنبيائه ورسله، فلا يقبل عبادة إلّا ما كان موافقا لدلالتهم، وقد قال :( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ ) (٤) .
وأمّا إن كان المعنيّ بالخطاب هو صلّى الله عليه وآله من دون تقدير خافض ومضاف فيرد هنا سؤال ؛ وهو أنّه هو الهادي للكلّ إلى أقوم السبل ؛ كما قال :( وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ) (٥) وقال :( وَيَهْدِيَكُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً ) (٦) وقد كان على صراط مستقيم من التوحيد وغيره، كما قال :( إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ) (٧) وكلّ هداية فهو مسبوق بضلالة، وهو صلّى الله عليه وآله لم يشبه ضلالة أصلا ؛ بل كان على بيّنة من أوّل خلقه؟
وللجواب عن هذا السؤال وجوه من المقال :
منها : أنّ كلّ عبد وإن بلغ في كماله ما بلغ إلّا أنّه محتاج إلى ربّه في كلّ آن
__________________
(١) الزخرف : ٤٣.
(٢) يس : ٦١.
(٣) آل عمران : ٥١.
(٤) آل عمران : ٨٥.
(٥) المؤمنون : ٧٣.
(٦) الفتح : ٢.
(٧) يس : ٣.
من الآنات، فإنّه لا يخرج عن حدّ الإمكان في حين من الأحيان، والممكن كما هو مفتقر في حدوثه إلى ربّه كذلك مفتقر في بقائه إليه تعالى، وقد قرّر ذلك في الحكمة.
ولا ريب أنّ هداية الرسول صلّى الله عليه وآله لم تحصل إلّا بفعل الله تعالى ووحيه وتوفيقه، فهو صلّى الله عليه وآله مفتقر إليه في دوام هذه الهداية وبقائها والثبات على الصراط المستقيم، ولو لا عناية الحقّ وعصمته لزلّت قدمه عن الصراط ؛ كما قال :( لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ ) (١) .
فالمراد بـ «يهديك» يبقيك ويديمك ويثبّتك على هذا الصراط الّذي هداك إليه، وقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال في تفسير :( اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ ) (٢) ؛ يعني «أدم لنا توفيقك الّذي به أطعناك في ماضي أيّامنا حتّى نطيعك كذلك في مستقبل أعمارنا»(٣) .
قال بعض الأساطين : لمـــّـا كان العبد محتاجا إلى الهداية في جميع أموره آنا فآنا ولحظة فلحظة، فإدامة الهداية هي هداية اخرى بعد الهداية الاولى، فتفسير الهداية بإدامتها ليس خروجا عن ظاهر اللفظ.
ومنها : أنّ لكلّ أحد صراطا مستقيما بحسب رتبته ومقامه، وهو صلّى الله عليه وآله وإن كان هاديا للكلّ إلى أوضح السبل، إلّا أنّه محتاج إلى الله في أن يهديه إلى توحيده الخاصّ به الحاصل من التجلّي الكلّيّ الموجب للفناء
__________________
(١) يوسف : ٢٤.
(٢) الفاتحة : ٦.
(٣) بحار الأنوار ٢٤ : ٩.
الكلّيّ الّذي ترتفع به جميع التعيّنات الملكيّة والملكوتيّة والجبروتيّة.
وهذا المحو والارتفاع إمّا دفعيّ، وإمّا تدريجيّ، والأوّل يسمّى بالتجلّي الجلاليّ، والثاني بالجماليّ.
وكيف كان، فهذا المقام هو صراطه المستقيم المخصوص به، فالتنكير للتفخيم أو للنوعيّة، وحاصله على ما قدّمناه هو صرف التوجّه عن غير الله إلى الله والالتفات بالكلّيّة عن علائق النفس إلى الله :
إذا شئت أن تحيا فمت عن علائق |
من الحسّ خمس ثمّ عن مدركاتها |
|
فقابل بوجه النفس عالم قدسها |
فذاك حياة النفس بعد مماتها |
ومنها : أنّ المراد بالهداية في الآية هو كشف الأسرار الإلهيّة وحقائق الأشياء على ما هي، فإنّ الهداية أقسامها أربعة :
أحدها : ما عرفته وهو خاصّ بالأنبياء والأولياء ؛ كما قال :( أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ ) (١) وقال :( وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا ) (٢) .
وثانيها : إفاضة القوى الّتي يمكّن بها العبد من الاهتداء في مصالحه كالعاقلة والحواسّ الظاهرة والباطنة ؛ كما قال :( وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدى ) (٣) .
وثالثها : نصب الدلائل الفارقة بين الحقّ والباطل ؛ كما قال :
__________________
(١) الأنعام : ٩٠.
(٢) العنكبوت : ٦٩.
(٣) الأعلى : ٣.
( وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ ) (١) ؛ أي الخير والشرّ.
ورابعها : إرسال الرسل وإنزال الكتب بالدعوة والبيان.
وبالجملة : الهداية إنّما تستلزم سبق الضلالة في بعض أقسامها لا في جميعها.
ومنها : أنّ المراد بـ «الهداية» : «البيان» كما في قوله :( وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ ) (٢) ؛ أي بيّنّا لهم، وب «الصراط المستقيم» : «القرآن» لأنّه طريق يسلك بتاليه إلى الجنّة.
ووصفه بالاستقامة لكونه قائما ثابتا بالبرهان والحجّة بحيث لا يقدح فيه ريب المرتابين، ولا كيد الحاسدين.
أو لكونه قيّما لا عوج فيه من جهة الفصاحة والبلاغة :( وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً ) (٣) .
وهذا الوصف يحتمل كونه لحال الموصوف كما عرفته، وكونه لحال متعلّقة ؛ أي مستقيم سالكه ففي الإسناد تجوّز ؛ كما في قوله :( وَالنَّهارَ مُبْصِراً ) (٤) .
وقد ذكروا أنّ الخصلة الّتي بها يكمل محاسن الطريقة هي الاستقامة.
وقد يقال : إنّ الاستقامة هي الترقّي عن توحيد الأفعال إلى توحيد الصفات، وعنه إلى توحيد الذات.
__________________
(١) البلد : ١٠.
(٢) فصّلت : ١٧.
(٣) النساء : ٨٢.
(٤) يونس : ٦٧.
وكيف كان ففي وصف الصراط بالاستقامة في مواضع كثيرة من القرآن إشارة إلى أنّ الطرق الّتي يطلب فيها الحقّ وإن كانت كثيرة ؛ بل لا تعدّ ولا تحصى، إلّا أنّ المقصود المحبوب لله منها هو المستقيم المستوي الّذي يهتمّ الشيطان بصدّ العباد عنه ؛ كما قال :( لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ) (١) لأنّه الطريق المنتهي إلى النعيم، وغيره من الطرق صراط الجحيم ؛ كما قال :( فَاهْدُوهُمْ إِلى صِراطِ الْجَحِيمِ ) (٢) فالصراط المستقيم هو صراط الله ؛ كما أضافه إليه في كتابه، وغيره صراط الشيطان، وهمّه صرف عباد الله عن صراطه إلى صراطه.
والقول بأنّ كلّ أحد مظهر لاسم من أسماء الله ومربوب له، وجميع الأسماء منتسب إلى ذات واحدة، فجميع الطرق تنتهي الى الله ؛ كما قال :( إِلَى اللهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ) (٣) لا يقتضي انتهاء طريق الشيطان إلى الله ؛ بل الطرق الّتي هي مصاديق صراط الله المستقيم تنتهي إلى الله، فكلّ من الصلاة والزكاة والصوم وغيرها من العبادات الظاهريّة طريق إليه.
وكذلك كلّ من الأخلاق الحميدة كالعدل والجود والقناعة طريق إليه.
وكذلك كلّ من مراتب التوحيد والمعرفة طريق إليه ؛ كما أنّ كلّا من أضداد ذلك طريق إلى الشيطان فلا تغفل.
والحاصل : أنّ كلّ واحد من الخيرات نقطة من نقاط الخطّ المستقيم
__________________
(١) الأعراف : ١٦.
(٢) الصافّات : ٢٣.
(٣) الشورى : ٥٣.
الموهوم في الصراط المستقيم، وتبدّلها بحسب الأوقات والأشخاص لا يوجب اعوجاج هذا الخطّ. فافهم.
تتميم : ربّما يتوهّم أنّ استعمال الصراط في غير الطريق الحسّيّ من المسافة الّتي يتطرّق فيها بالحركة الحسّيّة المطلقة على كون الجسم متوسّطا بين المبدأ والمنتهى المسمّى بالحركة التوسّطيّة، وعلى الأمر الممتدّ في الخيال باستمرارها وسيلانها المسمّى بالحركة القطعيّة مجازيّ، لأنّ المتبادر من إطلاق هذا اللفظ هو الطريق الحسّيّ المذكور، وتبادر الغير آية المجاز ؛ كما فصّل في محلّه.
وأنت خبير بأنّ لكلّ معنى من المعاني روحا وقالبا، واللفظ موضوع للمعنى بملاحظة روحه وحقيقته من غير ملاحظة خصوصيّة قالب من قوالبه، فصراط الشيء هو ما يفضي إليه بحسبه، فإن كان المفضي إليه جسما فصراطه جسم، وإن كان أمرا عقليّا فصراطه كذلك، والحركة عقليّة معنويّة.
وقد فصّل الغزاليّ هذا في إحيائه بما لا مزيد عليه، وتبعه المحدّث الكاشاني في مقدّمات الصافي، فتأمّل.
( وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْراً عَزِيزاً ) «النصر» الإعانة، ونصره منه : نجّاه وخلّصه، ويقال : نصر الغيث الأرض : إذا عمّها، والله تعالى أعان رسوله في جميع أموره، ولا سيّما على دفع أعدائه، ونجّاه من مكائدهم وأذاهم، وإنّما أرادوا ليطفئوا نوره بأفواههم والله متمّ نوره ولو كره المشركون.
وكان الشيطان من أعدى أعدائه، لكونه لعنه الله مضلّا، وكونه صلّى الله عليه وآله مظهر الاسم الهادي، ومنشأ العداوة هو التضادّ، فعصمه الله منه كما
عصمه من الناس فقال :( وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ) (١) فهو صلّى الله عليه وآله معصوم من الخطأ والنسيان بإعانة الله، ومن شرور الأعداء بحفظه ودفعهم عنه، ومن صغائر المعاصي وكبائرها بدفع الشيطان عنه حتّى قتله بيده، وعمّه بجوده وإحسانه حيث جعله مرآة لجميع أسمائه الحسنى حاكيا عن تمام صفاته العليا، ولذا قال له : خلقتك لأجلي، وخلقت الأشياء لأجلك.
فصار سائر الأنبياء حاكين عنه صلّى الله عليه وآله مظهرين لأمره على حسب مراتبهم في معرفة الأسماء والصفات من علم اليقين أو عين اليقين، وأمّا هو صلّى الله عليه وآله فقد عرف الأسماء والصفات بحقّ اليقين حيث كان مظهرا للجميع بالتجلّي الأوّل من دون توسّط واسطة غيريّة ؛ بل كان هي نفس التجلّي الأوّل، وليس لأحد أن ينكر اختلاف مراتب الخلق في مراتب معرفة الحقّ تعالى.
وقد أجاد بعض العارفين حيث قال : وفيه ـ أي في مقام معرفة الصفات والأسماء ـ تتفاوت مراتبهم، فليس من يعلم أنّه تعالى عالم قادر على الجملة كمن شاهد عجائب آياته في ملكوت السماوات والأرض، وخلق الأرواح والأجساد، واطّلع على بدائع المملكة، وغرائب الصنعة، ممعنا في التفصيل، ومستقصيا دقائق الحكمة، ومستوفيا لطائف التدبير، ومتّصفا بجميع الصفات الملكيّة المقرّبة من الله، نائلا لتلك الصفات نيل اتّصاف بها ؛ بل بينهما من البون البعيد ما لا يكاد يحصى.
وفي تفاصيل ذلك ومقاديره تتفاوت الأنبياء والأولياء، ولن يصل إلى
__________________
(١) المائدة : ٦٧.
فهمك إلّا بمثال، ولله المثل الأعلى.
ثمّ مثّل بمثال حاصله : أنّ العالم المتقن يعرفه بوّابه، ويعرفه تلميذه، والبوّاب يعرفه أنّه عالم بالشرع، ومصنّف فيه، ومرشد خلق الله إليه على الجملة، والتلميذ يعرفه لا كمعرفة البوّاب.
بل يعرفه معرفة محيطة(١) بتفاصيل صفاته ومعلوماته.
بل العالم الّذي يحسن عشرة أنواع من العلوم لا يعرفه بالحقيقة تلميذه الّذي لم يحصّل إلّا نوعا واحدا فضلا عن خادمه الّذي لم يحصّل شيئا من العلوم.
بل الّذي حصّل علما واحدا فإنّما عرف على التحقيق عشرة إن ساواه في ذلك العلم حتّى لم يقصر عنه، فإن قصر عنه فليس يعرف بالحقيقة ما قصر عنه إلّا باسم وإبهام الجملة، وهو أنّه يعلم شيئا سوى ما علمه.
قال : فافهم تفاوت الخلق في معرفة الله، فبقدر ما انكشف لهم من معلومات الله، وعجائب مقدوراته، وبدائع آياته في الدنيا والآخرة، والملك والملكوت، تزداد معرفتهم، وتقرب معرفتهم من معرفة الحقيقة. انتهى.
وبالجملة : رسولنا الخاتم لكونه جامعا لجميع الكمالات بالإفاضة الكلّيّة والجود العامّ من الذات واقع في أعلى مراتب المعرفة بالأسماء والصفات، والأنبياء كلّهم لعدم حكايتهم عن الجميع واقفون تحت مرتبته، ولذا قال : لو كان موسى حيّا ما وسعه إلّا اتّباعي(٢) .
__________________
(١) «أ» : محيط.
(٢) بحار الأنوار ٢ : ٩٩، معاني الأخبار : ٢٨٢.
وقال : آدم ومن دونه تحت لوائي [يوم القيامة](١) .
وقال عليه السلام :
إنّي وإن كنت ابن آدم صورة |
فلي فيه معنى شاهد بأبوّتي |
ولا يخفى عليك أنّ «النصر» على المعنى الأوّل متعدّ إلى الثاني بـ «على» وعلى الثاني بـ «من» وعلى الثالث لا يتعدّى إلّا إلى الواحد، وهما أيضا متضمّنان للأوّل الّذي هو الأصل في هذا اللفظ، وحذف الثاني في الأوّلين يفيد العموم لهما وللثالث، ولا يلزم الاستعمال في أكثر من معنى واحد لو أريد به القدر المشترك حقيقة أو تجوّزا. فافهم.
وكيف كان، فيحتمل أن يراد بـ «النصر» ترويج دينه، ورفع ذكره، أو إظهاره على الدين كلّه ولو في زمان الرجعة، وقد سئل الصادق عليه السلام عن قوله تعالى :( إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ ) (٢) فقال عليه السلام : ذلك والله في الرجعة، أما علمت أنّ أنبياء الله كثيرة لم ينصروا في الدنيا وقتلوا، والأئمّة من بعدهم قتلوا ولم ينصروا وذلك في الرجعة(٣) . انتهى.
أو غلبته على الكفّار المعارضين له بالحجج الباهرة الّتي من جملتها ؛ بل أعلاها : القرآن ؛ الّذي عجزوا عن الإتيان بمثل أقصر آية منه ؛ ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فلو لا ذلك لما اختاروا تجشّم مكائد الحرب معه في مواطن
__________________
(١) بحار الأنوار : ١٦ : ٤٠٢.
(٢) غافر : ٥١.
(٣) بحار الأنوار ٦٧ : ٤٧.
كثيرة بتضييع الأموال، وإتلاف النفوس.
وفي رواية عن الرضا عليه السلام : فأمّا قوله عزّ وجلّ :( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (١) فإنّه يقول : ولن يجعل الله لكافر على مؤمن حجّة، ولقد أخبر الله عزّ وجلّ عن كفّار قتلوا النبيّين بغير حقّ، ومع قتلهم إيّاهم لن يجعل الله لهم على أنبيائه سبيلا من طريق الحجّة(٢) . انتهى.
وكيف كان، فقد نصر الله رسولنا في حياته في مواطن كثيرة مع قلّة عدده وعدّته، ووقائعه في غزواته معروفة، وبعد وفاته بأصحابه وخلفائه وترويج دينه وإعلاء كلمته يوما فيوما مع كثرة الملحدين، وشدّة عناد المنافقين، وسينصره في زمان الرجعة قبل يوم القيامة بما قرع سمعك من الأخبار المتواترة المشتملة على ما يخصّه الله في أهل بيته وشيعتهم من الدولة العظيمة، والسلطنة القويمة، وفي القيامة بقبول شفاعته في أمّته ؛ بل في جميع الأمم، وبعثه المقام المحمود، وتخصيصه بلواء الحمد، وتاج الكرامة، والحوض، وغير ذلك ممّا لا يخفى على من تتبّع الآيات والأخبار.
فأيّ نصر أعزّ وأمنع من نصر الله لهذا الرسول الّذي كان في أوّل أمره بحسب الظاهر يتيما وحيدا فقيرا لا عدد ولا عدّة له، فشرح الله صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، وأكثر له الذرّيّة الطيّبة، وأعطاه الكوثر المفسّر بذلك وبغيره من المراتب العالية، فصلّى الله عليه وآله صلاة دائمة طيّبة.
__________________
(١) النساء : ١٤١.
(٢) بحار الأنوار ٤٤ : ٢٧١.
و «العزيز» القويّ والغالب.
قال الطبرسيّ رحمه الله : النصر العزيز هو ما يمتنع به من كلّ جبّار عنيد وعات مريد، وقد فعل ذلك بنبيّه ؛ إذ صيّر دينه أعزّ الأديان، وسلطانه أعظم السلطان(١) . انتهى.
فالوصف لحال الموصوف، ويحتمل كونه لمتعلّقه ؛ أي نصر الغيريّة المنصور، فوصف بوصفه مبالغة ؛ كما في قوله :( عِيشَةٍ راضِيَةٍ ) (٢) .
ويحتمل أن يكون المراد بـ «العزّة» القلّة من قولهم : عزّ اللحم : إذا قلّ ؛ أي نصرا [يكاد لا يوجد](٣) مثله، فإنّ هذا النصر مخصوص برسولنا من بين الرسل، فمن المحتمل أن يراد به نصرة القائم من ولده.
اللهمّ أعزّه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا!
( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ) لعلّ التعبير بكلمة «هو» الموضوعة لضمير الغائب المناسبة إنزال السكينة في القلوب، فإنّه أمر غيبيّ لا يدرك بمشاهدة العيون ؛ بل هو سرّ مستسرّ بين المحبّ والمحبوب.
بين المحبّين سرّ ليس يفشيه |
قول ولا قلم للخلق يحكيه |
وقد ذكر بعض العارفين : أنّ ال «هو» هو اعتبار الذات بحسب(٤) الغيبة.
غائب ز حقّ است و «هو»ازآن مى گويد |
گم كرده هويّت وبه «هو» مى جويد |
__________________
(١) مجمع البيان، المجلّد ٥ : ١٦٩.
(٢) الحاقّة : ٢١.
(٣) «ب» : لا يكاد ولا يوجد.
(٤) ليست في «أ».
وقد يقال : إنّ مقام ألهو المعبّر عنه بالهاهوت أعلى من مقام اللاهوت المأخوذ من اسم الجلالة، فإنّ الأوّل كناية عن كنه الذات المجرّد عن جميع الاعتبارات، وهو الّذي لا يعلم ما هو إلّا هو، فلا سبيل في هذا المقام لإشارة، وعبارة، واسم، ورسم، ووصف، وصفة، وتعريف، ومعرفة، سوى أنّه هو، ولا هو إلّا هو، فإنّه مقام الهوهويّة الذاتيّة، والثاني عن الذات باعتبار اسم الذات، ولا مشاحّة في الاصطلاحات.
وكيف كان، ففي هذا التعبير إشارة إلى كمال عناية الحقّ بالمؤمنين بإنزال السكينة في قلوبهم.
ومن المحتمل أن يكون إشارة إلى أنّ هذا الإنزال لا يكون إلّا بعد غيبة المؤمن عن نفسه، وفقده العلائق البشريّة، وتجريده القلب عن ذكر ما سوى الربّ، وفنائه في شهود الحقّ بحيث لا يصرفه عنه استعمال جوارحه، ويسمّى هذا المقام بسجود القلب :
در شهود حقّ ار فنا گردى |
غرق درياى ما چه ما گردى |
وقد وصف الله هؤلاء المؤمنين برجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ولعلّ في التعبير بالإنزال دون التنزيل على القول بالفرق بينهما بدلالة الثاني على التدريج دون الأوّل إشارة إلى حصول حالة السكينة دفعة ؛ إذ مادام السالك في السعي والسير لا يكون مطمئنّا بالوصول إلى المقصد الأعلى، وهو النجاة عن حبائل الشيطان، ومكائد النفس الأمّارة، والفوز بالحياة الملكوتيّة، فإذا وصل إلى هذا المقصد بحسب استعداده يحصل له القرار والسكون، ويزول عن قلبه خوف الابتلاء بوساوس الشيطان، وصدّه عن
الصراط المستقيم ؛ كما قال :( لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ) (١) فإنّه بالمرصاد في جميع الجهات لإضلال عباد الله ؛ كما قال :( لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمانِهِمْ وَعَنْ شَمائِلِهِمْ ) (٢) إلى آخره.
ولكن لم يقل ومن فوقهم، ولا من تحتهم، لأنّ الأوّل طريق الحقّ إلى الخلق، والثاني طريق الخلق إلى الحقّ، والطريقان إلى القلب، ومن القلب، فمتى أراد الحقّ بعبد خيرا جذبه وألهم في نفسه أن يسلك طريق الحقّ من قلبه، أو سلك العبد أوّلا فيجذبه الحقّ، ويسمّى الأوّل بال «مجذوب السالك» والثاني بال «سالك المجذوب».
والجذبة عبارة عن : تقرّب العبد إلى الحقّ بالعناية الإلهيّة، وتهيئة الحقّ له جميع ما يحتاج إليه في طيّ المنازل وقطع المراحل، فهي عبارة اخرى عن التوفيق الّذي هو خير رفيق في الأسفار.
وبالجملة : الطريق إلى الله من جهة القلب أسلم الطرق(٣) إذا كان سليما من آفات الرذائل ؛ كما قال :( إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ) (٤) وإلّا فالسالكون بغير هذا الطريق في خطر عظيم من وسوسة الشيطان الرجيم، وقلّ من وصل إلى المقصود بغير هذا الصراط المستقيم ؛ أي القلب السليم.
هزار تشنه درين ره فرو شدند ونديدند |
ز بوى وصل نسيمى ز كوى دوست نشانى |
__________________
(١) الأعراف : ١٦.
(٢) الأعراف : ١٧.
(٣) «أ» : الطريق.
(٤) الشعراء : ٨٩.
ولمّا كان القلب هو الجوهر النورانيّ المجرّد الّذي به يتحقّق إنسانيّة الإنسان، وكان بمنزلة عرش الرحمن ؛ بل عرشه حقيقة ومنظره ومحلّ رحمته ومعرفته ؛ كما قال : لا يسعني أرضي ولا سمائي ؛ بل يسعني قلب عبدي المؤمن(١) . أنزل سكينته فيه وجعله بمنزلة تابوت السكينة الّذي أنزله لبني إسرائيل، فكما أنّ سكينتهم كانت في التابوت، كان سكينة هذه الأمّة في القلوب المصفّاة بحبّ المحبوب الّذي لا ينام ولا يموت.
وكما أنّ أولاد يعقوب عليه السلام كانوا أقوياء أعزّاء لا يغلبهم الأعداء مادام هذا التابوت فيهم، فلمّا ذهب به العمالقة الجبّارون صاروا ضعفاء أذلّاء قتل كثيرا منهم جالوت وأسرهم وأخرجهم من بلادهم، فكذلك أولاد يعقوب عليه السلام.
الروح الانساني وهي القوى الروحانية قويّة غالبة مادام تابوت سكينة القلب فيهم، فإذا ذهب به منهم جنود جالوت النفس الأمّارة فهي في غاية الذلّ والمهانة، إلّا أن يوفّقهم للتوبة والإنابة، فيرجع إليهم السكينة في تابوت قلوبهم بمعونة طالوت العقل والنفس المطمئنّة، فيقتل داود العلم جالوت الجهل والنفس الأمّارة، وكما أنّ تابوت بني إسرائيل كان تحمله الملائكة، كان قلوب المؤمنين حملتها يد الله ؛ حيث قال :( وَحَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ) (٢) وقال :( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ) .
__________________
(١) جاء هذا الحديث في البحار ٥٨ : ٣٩ هكذا : لم يسعني سمائي ولا أرضي، ووسعني قلب عبدي المؤمن.
(٢) الإسراء : ٧٠.
وكما أنّ تابوت بني إسرائيل كان مشتملا على صور الأنبياء كانت قلوب المؤمنين متّصفة بأخلاق الأنبياء وسيرتهم من الصفات الحميدة، ومزيّنة بالعلوم الربّانيّة، والأسرار الإلهيّة.
ولذا قيل : إنّ الآيات الّتي كانت في بني إسرائيل ظاهرة لا بدّ من وقوعها في هذه الامّة ولو في الباطن، وقد روي مستفيضا أنّه صلّى الله عليه وآله قال : يكون في امّتي ما كان في بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، والقذّة بالقذّة(١) .
وفي بعض الروايات : أنّ تابوت بني إسرائيل كان هو الصندوق الّذي أنزله الله على آدم عليه السلام وفيه صور أولاده من الأنبياء والأولياء وغيرهم، وقد عهد في محافظته إلى شيث، وكان من بعده بيد من كان حاملا لنور خاتم الأنبياء صلّى الله عليه وآله.
وفي بعضها : أنّه الصندوق الّذي أنزله الله إلى أمّ موسى عليه السلام فوضعته فيه وألقته في اليمّ، وكان في بني إسرائيل يتبرّكون به، فلمّا حضر موسى الوفاة وضع فيه الألواح ودرعه وما كان عنده من آيات النبوّة وأودعه يوشع وصيّه، فلم يزل التابوت بينهم حتّى استخفّوا به وكان الصبيان يلعبون به في الطرقات، فلم يزل بنو إسرائيل في عزّ وشرف مادام التابوت بينهم، فلمّا عملوا بالمعاصي واستخفّوا بالتابوت رفعه الله عنهم، فلمّا سألوا النبيّ وبعث الله طالوت إليهم ملكا يقاتل ردّ الله عليهم التابوت(٢) .
وقد اختلفوا في المراد من السكينة الّتي كانت في هذا التابوت على
__________________
(١) بحار الأنوار : ٣٦ : ٢٨٤ ؛ إلّا أنّ فيه بدل كلمة «يكون»، كلمة «كائن».
(٢) راجع بحار الأنوار : ١٣ : ٤٣٩.
حسب اختلاف ما ورد فيها من الأخبار، ففي بعضها : أنّها كانت فيه ريح هفّافة من الجنّة لها وجه كوجه الإنسان(١) .
وفي بعضها : أنّها ريح تخرج من الجنّة لها صورة كصورة الإنسان، ورائحة طيّبة(٢) .
وفي بعضها : أنّها روح الله [فكان يتكلّم](٣) ويخبرهم إذا اختلفوا في شيء(٤) .
وفي بعضها : أنّها حيوان على صورة الهرّة ؛ لها وجه كوجه الإنسان، وكانت تخرج من التابوت، فيفزع منها الأعداء، فينهزمون ويتفرّقون(٥) .
وفي بعضها : أنّها الطست الّذي يغسل فيه قلوب الأنبياء(٦) . وقيل فيها أقوال اخر.
و «السكينة» بفتح السين وتخفيف الكاف، وبكسر السين وتشديد الكاف في أصل اللغة هي الطمأنينة، وسكون النفس ضدّ القلق والاضطراب، وبذلك فسّرت أيضا في الآية، وقد يفسّر أيضا بوجوه اخر يمكن إرجاعها إلى ذلك :
منها : الإيمان، وقد روى الكلينيّ بسنده عن أبي حمزة عن أبي جعفر
__________________
(١) بحار الأنوار ٩٠ : ١١٠.
(٢) بحار الأنوار ١٢ : ١٠٣.
(٣) «أ» : وكان يتكلّمهم.
(٤) بحار الأنوار ١٣ : ٤٤٣، مع اختلاف في بعض ألفاظه.
(٥) بحار الأنوار ١٣ : ٤٤٣، مع اختلاف في بعض ألفاظه.
(٦) بحار الأنوار ١٣ : ٤٤٣.
عليه السلام قال : سألته عن قول الله :( أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ) قال : «هو الإيمان».
قال : وسألته عن قول الله :( وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ) (١) قال : هو الإيمان(٢) .
وبسنده عن محمّد بن مسلم عنه عليه السلام أيضا قال : السكينة الإيمان(٣) .
وبسنده عن حفص بن البختريّ وهشام بن سالم وغيرهما عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ ) إلى آخره قال : هو الإيمان(٤) .
وبسنده عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى :( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ ) إلى آخره قال : هو الإيمان.
قال : قلت :( وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ) قال : هو الإيمان. وعن قوله :( وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى ) (٥) قال : هو الإيمان(٦) .
أقول : مرادهما عليهما السلام من الإيمان هو الكامل منه ؛ أي الاعتقاد الجازم الثابت الّذي لا يزول بتشكيك المشكّكين، وشبهة الملحدين، وهو المعبّر عنه باليقين.
ولذا عبّر في الآية بـ «في» الدالّة على الظرفيّة، ففيها إشارة إلى تمكّن الإيمان في قلوبهم تمكّن المظروف من الظرف ورسوخه فيه، وأمّا غيره
__________________
(١) المجادلة : ٢٢.
(٢) الكافي ٢ : ١٥.
(٣) الكافي ٢ : ١٥.
(٤) الكافي ٢ : ١٥.
(٥) الفتح : ٢٦.
(٦) الكافي ٢ : ١٥.
فهو في معرض الزوال والتزلزل.
وفي رواية جابر قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : يا أخا جعف، إنّ الإيمان أفضل من الإسلام، وإنّ اليقين أفضل من الإيمان، وما من شيء أعزّ من اليقين(١) .
وفي رواية الوشّاء عن أبي الحسن عليه السلام : الإيمان فوق الإسلام بدرجة، والتقوى فوق الإيمان بدرجة، واليقين فوق التقوى بدرجة، وما قسّم في الناس شيء أقلّ من اليقين(٢) .
وبالجملة : لمـــّـا كانت الآية في مقام الامتنان على المؤمنين، لا بدّ أن يكون المراد بالإيمان الّذي أنزله في قلوبهم هو اليقين الكامل الّذي لا يزول ولا يتبدّل إلى الشكّ والحيرة والقلق أبدا ؛ إذ غيره قد يسلب وقد يتزلزل صاحبه ؛ كما في المعارين والمستودعين، قال الكاظم عليه السلام : إنّ الله خلق النبيّين على النبوّة، فلا يكونون إلّا أنبياء، وخلق المؤمنين على الإيمان، فلا يكونون إلّا مؤمنين، وأعار قوما إيمانا، فإن شاء تمّمه لهم، وإن شاء سلبهم إيّاه(٣) .
قال : وفيهم جرت( فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ) (٤) (٥) .
وقال أيضا في رواية اخرى : إنّ الله خلق خلقا للإيمان لا زوال له، وخلق
__________________
(١) بحار الأنوار ٧٠ : ١٣٥.
(٢) بحار الأنوار ٧٠ : ١٣٦.
(٣) بحار الأنوار ٦٩ : ٢٢٦.
(٤) الأنعام : ٩٨.
(٥) الكافيّ ٢ : ٤١٨.
خلقا للكفر لا زوال له، وخلق خلقا بين ذلك أعارهم الله الإيمان يسمّون المعارين ؛ إذا شاء سلبهم(١) .
وقال أيضا عليه السلام : إنّ العبد يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، وقوم يعارون الإيمان ثمّ يسلبونه ويسمّون المعارين(٢) .
أقول : فغير المعارين هم الّذين كتب الله في قلوبهم الإيمان وثبّته فيها.
ويحتمل أن يراد بالمؤمنين غير من خلقوا للإيمان، فإنّ المخلوقين لا يكونون إلّا مؤمنين، فهم أرباب السكينة من أوّل الأمر، فلا حاجة إلى إنزالها في قلوبهم. فافهم.
ومنها : نور معرفة الإمام المعصوم عليه السلام المشعشع لقلوب العارفين به، فإنّ من لا يعرف إمام زمانه يكون حائرا متحيّرا في دينه، متزلزلا في عقيدته، غير مطمئنّ بنجاته، قال الباقر عليه السلام : كلّ من دان الله عزّ وجلّ بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول، وهو ضالّ متحيّر، والله شانئ لأعماله، ومثله كمثل شاة ضلّت عن راعيها وقطيعها، فهجمت ذاهبة وجائية يومها، فلمّا جنّها الليل بصرت بقطيع غنم مع غير راعيها، فحنّت إليها واغترّت بها، فباتت معها في مربضها، فلمّا أن ساق الراعي قطيعه أنكرت راعيها وقطيعها فهجمت متحيّرة تطلب راعيها وقطيعها، فبصرت بغنم مع راعيها فحنّت إليها واغترّت بها، فصاح بها
__________________
(١) بحار الأنوار ٤٨ : ١١٦.
(٢) بحار الأنوار ٦٩ : ٢٢٥.
الراعي : الحقي براعيك وقطيعك فأنت تائهة متحيّرة عن راعيك وقطيعك فهجمت ذعرة، متحيّرة، تائهة، لا راعي لها يرشدها إلى مرعاها أو يردّها، فبينا هي كذلك إذا اغتنم الذئب ضيعتها، فأكلها، كذلك والله من أصبح من هذه الامّة لا إمام له من الله عزّ وجلّ ظاهر عادل، أصبح ضالّا تائها، وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق(١)
ومنها : ذكر الله القلبيّ ؛ كما قال :( أَلا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ) (٢) وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : قال الله : إذا كان الغالب على قلب عبدي ذكري تولّيت أموره، وكنت جليسه وأنيسه. انتهى(٣) .
أقول : كيف لا يطمئنّ ولا يسكن من كان الله جليسه وأنيسه ومتولّي أموره؟!
ومنها : حبّ الله وولايته ؛ كما قال :( إِنَّ أَوْلِياءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ) (٤) .
ومنها : التوكّل على الله وتفويض الأمر إليه ؛ كما قال :( وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ) (٥) .
ومنها : صلح الحديبيّة، فإنّه صار موجبا لسكون المؤمنين، واطمئنانهم من المشركين لمـــّـا عاهدوا أن لا يتعرّضوا لهم وإن حجّوا البيت.
__________________
(١) الكافي ١ : ١٨٣.
(٢) الرعد : ٢٨.
(٣) في البحار ٩٣ : ١٦٢ ما هو قريب منه.
(٤) يونس : ٦٢.
(٥) الطلاق : ٣.
ومنها : أن يفعل الله بهم اللطف الّذي يحصل لهم عنده من البصيرة بالحقّ ما تسكن إليه نفوسهم، قاله الطبرسيّ رحمه الله : ثمّ قال : وذلك بكثرة ما ينصب لهم من الأدلّة الدالّة عليه، فهذه النعمة التامّة للمؤمنين خاصّة، وأمّا غيرهم فتضطرب نفوسهم لأوّل عارض من شبهة ترد عليهم ؛ إذ لا يجدون برد اليقين وروح الطمأنينة في قلوبهم(١) .
ومنها : النصرة للمؤمنين، لتسكن بذلك قلوبهم، ويثبتوا في القتال.
ومنها : ما أسكن قلوبهم من التعظيم لله ولرسوله. فافهم.
ثمّ الفرق بين السكينة والوقار، أنّ الأوّل هو السكون في القلب، والثاني في الجوارح.
وربّما يقال : إنّ السكينة هيئة بدنيّة تنشأ من اطمئنان الأعضاء، والوقار هيئة نفسانيّة تنشأ من ثبات القلب. وهو كما ترى.
والطمأنينة أعمّ منهما، يقال : اطمأنّ قلبي.
وتجب الطمأنينة في الصلاة.
( لِيَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيمانِهِمْ ) يصلح كونه تعليلا لكلّ واحد من الأفعال المتقدّمة ولجميعها، إلّا أنّ الظاهر أنّه علّة لإنزال السكينة لقربه وأكثريّة ارتباطه، وفي المقام سؤال، وهو أنّ الإيمان ليس إلّا التصديق بالله وبما جاء به رسوله، وهو أمر واحد، فكيف يقبل الزيادة والنقصان؟ فمتى تحقّق المعنى المذكور في شخص فهو مؤمن، وإلّا فلا؟
والجواب عنه من وجوه :
__________________
(١) مجمع البيان، المجلّد ٥ : ١٦٩.
أحدها : إنّ الأمر الواحد كما يكون متواطئا، كذلك قد يكون مقولا بالتشكيك كالوجود عند الفهلويّين من الحكماء، لقولهم بأنّه حقيقة واحدة ذات مراتب متعدّدة ؛ أي مقولة بالتشكيك على القويّ والضعيف، وإن ذهب المشّائيّون إلى أنّ هذه المراتب حقائق متباينة، وكالنور المختلف شدّة وضعفا، والبياض والسواد وغيرها من الموضوع للمعنى الواحد الكلّيّ المقول بالتشكيك على الجزئيّات المتفاوتة بالقوّة والضعف، والأوّليّة والأولويّة وضدّهما.
إذا عرفت هذا، فاعلم أنّ الإيمان وإن كان هو مجرّد التصديق المذكور، ولكنّ مراتبه مختلفة متفاوتة بحسب أسبابه من : علم اليقين، وعين اليقين، وحقّ اليقين، وبحسب درجاته ومنازله بحسب الأخلاق الحسنة كثرة وقلّة، وشدّة وضعفا، وبحسب الاعتقادات الحقّة كذلك، وبحسب الأعمال الصالحة كذلك، وبحسب الاستعدادات والقابليّات كذلك، وبحسب الأزمان والأوقات.
فيمكن أن يكون الشخص مع كونه مصداقا للمؤمن في مرتبة يزيد إيمانه فيصير مصداقا للمؤمن في مرتبة أعلى من المرتبة السابقة، فيزداد مع إيمانه إيمانا أقوى، ضرورة أنّ المرتبة العليا حائزة للمرتبة السفلى مع الزيادة، فالعلوّ لا يقدح في صدق الإيمان على الإيمان المنحطّ عن هذه الدرجة ؛ نظير النور الحسّيّ، فإنّه طبيعة مشكّكة ذات مراتب متفاوتة مع كونه موضوعا للظاهر بنفسه، المظهر لغيره.
قال بعض الأفاضل : فالاختلاف بين الأنوار ليس اختلافا نوعيّا ؛ بل
بالقوّة والضعف، فإنّ المعتبر في النور أن يكون ظاهرا بالذات، مظهرا للغير. وهذا متحقّق في كلّ واحدة من مراتب الأشعّة والأظلّة، فلا الضعف قادح في كون المرتبة الضعيفة نورا، ولا القوّة والشدّة، ولا التوسّط شرط أو مقوّم إلّا للمرتبة الخاصّة، بمعنى ما ليس بخارج عنها أو قادح فالقويّ هو النور، والمتوسّط أيضا هو هو، وكذا الضعيف، فالنور عرض عريض باعتبار مراتبه البسيطة، ولكلّ مرتبة أيضا عرض باعتبار إضافتها إلى القوابل المتعدّدة. انتهى كلامه رفع مقامه.
فالكلام في الإيمان هو الكلام في النور حرفا بحرف، بل هو النور الحقيقيّ الّذي تستنير به قلوب المؤمنين، وصدور العارفين :( وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ ) (١) .
ويدلّ على ما ذكرناه جملة من الروايات ؛ ففي رواية ابن أبي الأحوص عن الصادق عليه السلام : إنّ الله عزّ وجلّ وضع الإيمان على سبعة أسهم، على : البرّ، والصدق، واليقين، والرضا، والوفاء، والعلم، والحلم، ثمّ قسّم ذلك بين الناس، فمن جعل فيه هذه السبعة الأسهم فهو كامل محتمل، وقسّم لبعض الناس السهم، ولبعض السهمين، ولبعض الثلاثة حتّى انتهوا إلى سبعة، ثمّ قال : لا تحملوا على صاحب السهم سهمين، ولا على صاحب السهمين ثلاثة فتبهضوهم، ثمّ قال : كذلك حتّى ينتهي إلى سبعة(٢) . انتهى.
وفي رواية القراطيسيّ عنه عليه السلام : إنّ الإيمان عشر درجات بمنزلة
__________________
(١) النور : ٤٠.
(٢) الكافي ٢ : ٤٢.
السلّم يصعد منه مرقاة بعد مرقاة، فلا يقولنّ صاحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شيء، حتّى ينتهي إلى العاشر، فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك، وإذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة، فارفعه إليك برفق ولا تحملنّ عليه ما لا يطيق فتكسره [فإنّ من كسر مؤمنا فعليه جبره](١) .
وفي رواية شهاب عنه عليه السلام أيضا : إنّ الله تبارك وتعالى خلق أجزاء بلغ بها تسعة وأربعين جزء، ثمّ جعل الأجزاء أعشارا، فجعل الجزء عشرة أجزاء، ثمّ قسّمه بين الخلق فجعل في رجل عشر جزء، وفي آخر عشري جزء حتّى بلغ به جزء تامّا، وفي آخر جزء أو عشر جزء وآخر جزء وعشري جزء، وآخر جزء وثلاثة أعشار جزء، حتّى بلغ به جزءين تامّين، ثمّ بحساب ذلك حتّى بلغ بأرفعهم تسعة وأربعين جزء، فمن لم يجعل فيه إلّا عشر جزء لم يقدر على أن يكون مثل صاحب العشرين، فكذلك صاحب العشرين لا يكون مثل صاحب الثلاثة الأعشار، وكذلك من تمّ له جزء لا يقدر على أن يكون مثل صاحب الجزءين، ولو علم الناس أنّ الله عزّ وجلّ خلق هذا الخلق على هذا لم يلم أحد أحدا(٢) .
وثانيها : إنّ المراد بإيمانهم السابق هو الإسلام، وبالإيمان المزداد هو التصديق القلبيّ ؛ إذ الأوّل عبارة عن مجرّد الشهادتين باللسان ؛ كما قال :( قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي
__________________
(١) الكافي ٢ : ٤٤.
(٢) الكافي ٢ : ٤٤.
قُلُوبِكُمْ ) (١) وقال :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلى رَسُولِهِ ) (٢) إلى آخره.
فالإيمان المزداد ما هو أخصّ من الإسلام، قال سماعة : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخبرني عن الإسلام والإيمان أهما مختلفان؟ فقال : إنّ الإيمان يشارك الإسلام، والإسلام لا يشارك الإيمان. فقلت : فصفهما لي. فقال : الإسلام شهادة أن لا إله إلّا الله والتصديق برسول الله، به حقنت الدماء، وعليه جرت المناكح والمواريث، وعلى ظاهره جماعة الناس، والإيمان الهدى وما يثبت في القلوب من صفة الإسلام، وما ظهر من العمل به والإيمان أرفع من الإسلام بدرجة، إنّ الإيمان يشارك الإسلام في الظاهر، والإسلام لا يشارك الإيمان في الباطن، وإن اجتمعا في القول والصفة(٣) .
وثالثها : أنّ المراد بإيمانهم الحاصل هو التصديق الإجماليّ بكلّ ما يأتي به الرسول، وبالإيمان المزداد هو التصديق التفصيليّ. فتأمّل.
وهو أنّهم كلّما أمروا بشيء من الشرائع والفرائض كالصلاة والصيام والصدقات صدّقوا ؛ وذلك بالسكينة الّتي أنزلها الله في قلوبهم.
ورابعها : إنّ المراد بإيمانهم السابق الإيمان بالأصول، وبالإيمان المزداد الإيمان بالفروع.
وخامسها : إنّ المراد بإيمانهم معرفتهم على طريق علم اليقين،
__________________
(١) الحجرات : ١٤.
(٢) النساء : ١٣٦.
(٣) الكافي ٢ : ٢٥.
وبالإيمان المزداد معرفتهم بحقّ اليقين وعين اليقين، فإنّ مراتب المعرفة منحصرة في هذه الثلاث ؛ كما فصّل في محلّه.
وسادسها : إنّ المراد بإيمانهم السابق تصديقهم بالنبوّة، وبالإيمان المزداد تصديقهم بولاية عليّ بن أبي طالب عليه السلام وقد قال ابن عبّاس : إنّ أوّل ما أتاهم به النبيّ، التوحيد، فلمّا آمنوا بالله وحده أنزل الصلاة والزكاة، ثمّ الحجّ، ثمّ الجهاد، ثمّ ولاية عليّ بن أبي طالب، فازدادوا إيمانا إلى إيمانهم، وأتمّوه بولاية عليّ عليه السلام(١) .
وسابعها : إنّ المراد بإيمانهم هو الإيمان السلوكيّ الّذي لا يطمئنّ فيه قلب السالك، لكونه بين الخوف من عدم الوصول ورجائه، وبالإيمان المزداد هو الإيمان الوصوليّ الّذي يرتفع معه الخوف. فتفطّن.
ثمّ في قوله :( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ ) إلى آخره. إشارة إلى بطلان القول بالتفويض، كما أنّ قوله :( لِيَزْدادُوا ) يبطل القول بالجبر، فيثبت الأمر بين الأمرين الّذي هو أوسع ممّا بين السماء والأرض ؛ كما يرشد إليه قوله :( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) (٢) فالعمل من العبد، والمعونة من الربّ.
وفي التعبير بـ «مع» المشعرة بالاستقلال إشعار بتماميّة إيمانهم السابق في حدّ نفسه بالنسبة إلى تلك الحال، نظير تماميّة النطفة قبل أوان صيرورتها علقة، وتماميّة العلقة قبل زمان كونها مضغة، وهكذا.
فإنّ تماميّة الشيء هو كونه على ما ينبغي أن يكون عليه في زمانه وأوانه،
__________________
(١) انظر : مجمع البيان، المجلّد ٥ : ١٦٩.
(٢) الفاتحة : ٥.
والتماميّة والنقصان أمران إضافيّان، فتكون بداية شيء نهاية لشيء آخر، وقد يكون أمر حسنة بالنسبة إلى شخص، سيّئة بالنسبة إلى آخر، ولذا لا يرتضى للخواصّ توحيد العوامّ وإن كان مرضيّا بالنسبة إليهم، وتوحيد الخواصّ غير مرضيّ لخاصّ الخاصّ وإن كان مرضيّا لهم، ولذا ورد : إنّ حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين(١) .
ففي العدول عن «على» إلى «مع» إشعار بأنّهم يثابون على كلّ من الإيمانين على حدة، فيؤتون أجرهم مرّتين ؛ وإن كان أجرهم على الثاني أعظم، ولكن يشترط في إيتاء الأجر الموافاة على الإيمان وعدم التقصير في ترتيب مقدّمات فعليّة القابليّات في كلّ مرتبة حصلت للمكلّف بالوصول إليها، فإنّ الله لا يكلّف نفسا إلّا ما آتاها من الاستعداد، فهو مؤاخذ بتضييع هذه القابليّة والتفريط في استكمالها بالوصول إلى مقام الفعليّة قبل أن يفاجئه الموت :
ترسم نشده غوره، انگور، خزان آيد |
يا مى نشده، انگور، ماه رمضان آيد |
( وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً ) ذكر هذه الجملة بعد ذكر إنزال السكينة لزيادة اطمئنان المؤمنين وثباتهم، فإنّه إذا كان جميع جنود السماوات والأرض من الملائكة والجنّ والإنس مملوكين لله أو
__________________
(١) هذه الجملة مع معروفيّتها فإنّها ليست برواية، بل هي جملة معروفة عند العرفاء وعلماء الأخلاق، ويحتمل أن تكون صدرت من عالم، فظنّها الآخرون بأنّها رواية فنقلوها كالرواية والله العالم.
قائمين لنصرة أهل الله وهو مولى المؤمنين ووليّهم، فكيف تقلق نفوسهم، وتدحض أقدامهم، ولا تطمئنّ قلوبهم، وربّما يخصّ(١) الجنود بالملائكة ؛ كما قال :( وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها ) (٢) ونصرتهم له صلّى الله عليه وآله في غزوة بدر وغيرها معروفة.
ويمكن تفسير الجنود بالملكوت ؛ كما قال :( فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ) (٣) وملكوت كلّ شيء هو ما يقوم به ذلك الشيء من عالم الأرواح والملائكة.
وفي الكلّيّات : إنّ ملكوت الشيء عند الصوفيّة حقيقته المجرّدة اللطيفة الغير المقيّدة بقيود كثيفة جسمانيّة، ويقابله الملك بمعنى المادّة الكثيفة بالقيود. انتهى.
وربّما تفسّر جنود السماوات بالقوى والمدارك، وجنود الأرض بالأعضاء والجوارح، فإنّ أصلها التراب، كما أنّ أصل القوى والمدارك العقول والنفوس المجرّدة الّتي من السماوات.
والحاصل : أنّ من بيده تدبير أمور الخلق في العالم العلويّ والسفليّ لا يعجز عن نصر المؤمنين، إلّا أنّه لعلمه بعواقب الأمور وفعله على حسب المصالح الّتي يعلمها قد يؤخّر هذه النصرة ليتميّز(٤) الخبيث من الطيّب، والعاصي من المطيع، ويخرج الحيّ من الميّت، فلا يغرّنّك إمهال الفجّار
__________________
(١) «ب» : يختصّ.
(٢) التوبة : ٢٦.
(٣) يس : ٨٣.
(٤) «أ» : لتميّز.
لعلّهم يتوبون، ولا الإبقاء على الكفّار لما في أصلابهم من الأبرار، وإنّما يؤخّرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.
ومن المحتمل البعيد أن يراد بجنود السماوات حزب الله الغالبون ؛ وهم أولياؤه المتّقون الّذين علت همّتهم، وسمعت رتبتهم، فلم يلتفتوا إلى الزخارف الدنيويّة، فاتّصلوا بالمبادئ العالية من العقول المجرّدة، فرفعوا مكانا عليّا، وبجنود الأرض الأناسيّ الطبيعيّون المخلّدون إلى الأرض، الواقفون على حضيض الطبيعة، وهم أولياء الشيطان وحزبه، وهؤلاء وأولئك كلّهم مملوكون لله، والله عليهم بعواقب أمورهم، حكيم فيما يصنع بهم من الثواب والعقاب من دون أن يظلم أحدا منهم، فإنّه العدل الحكيم الّذي لا يجوز.
فقوله :( لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَكانَ ذلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوْزاً عَظِيماً * وَيُعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكاتِ الظَّانِّينَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً ) يمكن أن يكون تعليلا لما يفهم من قوله :( وَلِلَّهِ جُنُودُ ) إلى آخره من معنى التدبير على حسب المصلحة، والحكمة ففيه إشارة إلى أنّه يعطي كلّ ذي حقّ حقّه ؛ كما هو معنى العدل، فصنعه بالفريقين من الثواب والعقاب مقتضى العدل، فله الحجّة عليهم ولا حجّة لأحد عليه، فلا يسأل عمّا يفعل وهم يسألون.
وقيل : إنّه متعلّق بمحذوف ؛ أي أمر تعالى بالجهاد ليعرف المؤمنون نعمة الله فيه ويشكروها، أو يقتلوا أو يتحمّلوا مشاقّ الحرب فيدخلوا الجنّة،
ويعذّب الكفّار والمنافقين في الآخرة بنار الجحيم، وفي الدنيا بما غاظهم من نصرة المؤمنين وتسليطهم على المشركين.
وقيل : إنّه متعلّق بجميع ما يقدّم من الأفعال على سبيل التنازع، وليعلم أنّ الثواب والعقاب الحسّيّان المصوّران في النشأة الاخرى بصورة الجنّة والنار صورتان للقرب والبعد والأعمال الحسنة والسيّئة، فإنّ حقائق الأمور تظهر في تلك النشأة وتنكشف بالصور المحسوسة ؛ كما يرشد إليه أخبار كثيرة :
گاه از او لطف، گاه بلا مى رسد |
صورت اعمال ماست آنچه به ما مى رسد |
والفرق بين المنافق والمشرك أنّ الأوّل هو الّذي يبطن الكفر ويعلن بالإيمان، والثاني هو المعلن بالشرك.
وفي رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام : إنّ أهل مكّة ليكفرون بالله جهرة، وإنّ أهل المدينة أخبث من أهل مكّة ؛ أخبث منهم بسبعين ضعفا(١) . انتهى.
والفرق بين الكافر والمشرك أنّ الأوّل هو من أنكر ضروريّا من ضروريّات الدين وإن كان مقرّا بالتوحيد، والثاني من جعل مع الله إلها آخر.
وفي رواية عن الصادق عليه السلام : إنّ الكفر أقدم من الشرك وأخبث وأعظم(٢) .
وفي رواية اخرى : وذلك أنّ إبليس أوّل من كفر وكان كفره من غير
__________________
(١) الكافي ٢ : ٤٤٠.
(٢) في الكافي ٢ : ٣٨٤ وفيه : إنّ الكفر أقدم من الشرك.
شرك، لأنّه لم يدع إلى عبادة غير الله، وإنّما دعا إلى ذلك بعد فأشرك(١) . انتهى.
والمراد بظنّ السوء أنّ الكفّار يظنّون أنّ الله لا ينصر رسوله والمؤمنين، ولذا كان أبو سفيان يقول : أللّهمّ إنّ ديننا القديم ودين محمّد الحديث فانصر أيّ الدينين أحبّ إليك. و «السّوء» بالفتح والضمّ مصدر، وهما لغتان فيه، إلّا أنّ الأول غلب في أن يضاف إليه ما يراد ذمّه، والثاني فيما يراد وصفه به، فالمراد به : الشرّ.
وفي الصحاح وتقول : هذا رجل سوء بالإضافة، ثمّ تدخل عليه الألف واللام فتقول : هذا رجل السوء، قال الشاعر :
وكنت كذئب السوء لمـــّـا رأى دما |
بصاحبه يوما أحال على الدم |
قال الأخفش : ولا يقال الرجل السوء، ويقال الحقّ اليقين، وحقّ اليقين جميعا، لأنّ السّوء ليس بالرجل، واليقين هو الحقّ، ولا يقال : هذا رجل السوء ـ بالضمّ(٢) . انتهى.
وقد يقال : إنّ «السّوء» بالفتح مصدر، وبالضمّ الاسم منه، فإنّه ما يتحصّل من السوء ؛ كالغسل المتحصّل من الغسل، والوضوء الحاصل من الوضوء.
ودائرة السوء بالوجهين من القراءتين ما يرجع إليهم من ظنّهم بالله أنّه ينصرهم ولا ينصر المؤمنين.
__________________
(١) الكافي ٢ : ٣٨٦.
(٢) صحاح اللغة ١ : ٥٦ (سوأ).
وفسّرت بالهزيمة، وفيه إشارة إلى أنّ من أراد بمؤمن شرّا رجع هذا الشرّ إليه.
والدائرة مطلق الراجعة، ولذا كانت هذه الدائرة بالنسبة إلى الكفّار دائرة السوء، وبالنسبة إلى المؤمنين دائرة الخير، فهي لهم كما أنّ الأولى على الكفّار، فيمكن أن يكون الأمر الواحد خيرا من حيثيّة، وشرّا من اخرى، ومن هنا قالوا : إنّ الشرّ المحض من جميع الوجوه ليس بموجود. فافهم.
والمراد بغضب الله ما يترتّب على الغضب من الغايات، وكذا ما ينسب إليه تعالى من الأفعال الطبيعيّة.
واللعن : الطرد من ساحة القرب، والإبعاد عن مقام الرحمة :( وَمَنْ يَلْعَنِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً ) (١) .
والإعداد التهيئة ؛ أي هيّأ لهم أسباب دخول جهنّم بسبب قبولهم للكفر وخذلانه لهم بعد أن زاغوا إليه ؛ كما قال :( فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ ) (٢) .
وساءت جهنّم مصيرا لهم ومرجعا يرجعون إليها بعد أن كانت طينتهم منها، فإنّ كلّ شيء يرجع إلى ما منه بدؤه ؛ كما قال :( كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ) (٣) .
وفي رواية الثماليّ عن الباقر عليه السلام : إنّ الله خلقنا من أعلى علّيّين، وخلق قلوب شيعتنا ممّا خلقنا منه، وخلق أبدانهم من دون ذلك، فقلوبهم تهوي إلينا ـ إلى أن قال ـ وخلق عدوّنا من سجّين، وخلق قلوب شيعتهم ممّا
__________________
(١) النساء : ٥٢.
(٢) الصف : ٥.
(٣) الأعراف : ٢٩.
خلقهم منه، وأبدانهم من دون ذلك، فقلوبهم تهوي إليهم لأنّها خلقت ممّا خلقوا منه ؛ ثمّ تلا هذه الآية :( كَلَّا إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ * وَما أَدْراكَ ما سِجِّينٌ * كِتابٌ مَرْقُومٌ * وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ) (١) انتهى(٢) .
وبالجملة : الكافر أصله من جهنّم، فمرجعه إليها ؛ كما قال :( فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ ) (٣) وتفصيل ذلك لا يسعه هذا المختصر.
( وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَكانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً ) وتكرار الآية لتأكيد تقوية قلوب المؤمنين على الجهاد مع الكفّار، أو لأنّ الأولى لتأييد النصر لاتّصالها بذلك المؤمنين، والثانية لتأييد الانتقام والانتصار لاتّصالها بذكر المنافقين والمشركين، ولذا أبدل «عليما» بـ «عزيزا» والعزيز هو الغالب القاهر.
ومن المحتمل أن يكون المراد من جنود السماوات هو جنود العقل، ومن جنود الأرض هو جنود الجهل، قال الصادق عليه السلام : إنّ الله خلق العقل وهو أوّل خلق من الروحانيّين عن يمين العرش من نوره، فقال له : أدبر، فأدبر، ثمّ قال له : أقبل، فأقبل، فقال الله : خلقتك خلقا عظيما وكرّمتك على جميع خلقي، قال : ثمّ خلق الجهل من البحر الأجاج ظلمانيّا فقال له : أدبر، فأدبر، ثمّ قال له : أقبل، فلم يقبل، فقال له : استكبرت، فلعنه ثمّ جعل للعقل خمسة وسبعين جندا، فلمّا رأى الجهل ما أكرم الله به العقل وما أعطاه
__________________
(١) المطفّفين : ٧ ـ ١٠.
(٢) الكافي ١ : ٣٩٠.
(٣) القارعة : ٩.
أضمر له العداوة، فقال الجهل : يا ربّ هذا خلق مثلي خلقته وكرّمته وقوّيته وأنا ضدّه ولا قوّة لي به، فأعطني من الجند مثل ما أعطيته، فقال : نعم، فإن عصيت بعد ذلك أخرجتك وجندك من رحمتي، قال : قد رضيت، فأعطاه خمسة وسبعين جندا(١) إلى آخر الحديث، وهو طويل معروف، وفيه رموز يعرفها أهلها.
( إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً ) أمّا كونه صلّى الله عليه وآله شاهدا فلأنّ الرسول واسطة بين الله وعباده، له يد يأخذ منه تعالى، ويد يعطيهم ما يتلقّاه منه، فلا بدّ أن يكون مطّلعا على أعمالهم وإيمانهم وكفرهم، لتصحّ شهادته لهم وعليهم يوم القيامة، وإتمام الحجّة عليهم، وكذلك الإمام القائم بعده، فانّه الواسطة بين الرسول والأمّة، قال الصادق عليه السلام في قول الله عزّ وجلّ :( فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً ) (٢) : نزلت في امّة محمّد صلّى الله عليه وآله خاصّة ؛ في كلّ قرن منهم إمام منّا شاهد عليهم، ومحمّد صلّى الله عليه وآله شاهد علينا(٣) .
وعن بريد العجليّ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله :( وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ ) (٤) فقال عليه السلام : نحن الامّة الوسطى ونحن شهداء الله على خلقه وحججه في أرضه. قلت :
__________________
(١) الكافي ١ : ٢١.
(٢) النساء : ٤١.
(٣) الكافي ١ : ١٩٠.
(٤) البقرة : ١٤٣.
قول الله عزّ وجلّ :( مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ ) (١) قال : إيّانا عنى خاصّة( هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ ) في الكتب الّتي مضت وفي هذا القرآن( لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ ) فرسول الله الشهيد علينا بما بلّغنا عن الله عزّ وجلّ، ونحن الشهداء على الناس ؛ فمن صدّق صدّقناه يوم القيامة، ومن كذّب كذّبناه يوم القيامة(٢) . انتهى.
وفي رواية سليم بن قيس الهلاليّ عن عليّ عليه السلام قال : إنّ الله طهّرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه، وحجّته في أرضه، وجعلنا مع القرآن، وجعل القرآن معنا ؛ لا نفارقه ولا يفارقنا(٣) . انتهى. ونحوها أخبار اخر أوردها الكلينيّ في الكافي في باب أنّ الأئمّة شهداء الله على خلقه.
ومن المحتمل أن يكون المراد بكونه صلّى الله عليه وآله شاهدا أنّه صلّى الله عليه وآله حاك عن أسماء الله وصفاته، وبيّنة من الله على ثبوت هذه الأسماء والصفات للحقّ بما فيه من الكمالات والأخلاق الإلهيّة، فإنّه كان صلّى الله عليه وآله آية الله ومرآة أسمائه وصفاته، ولذا قال : من رآني فقد رأى الحقّ(٤) .
وأمّا كونه مبشّرا ونذيرا ؛ أي منذرا فلاتّصافه بصفة جمال الله ولطفه واتّصافه بصفة جلاله وقهره اللّتين يعبّر عنهما بيدي الله ؛ كما قال : خمرت
__________________
(١) الحج : ٧٨.
(٢) الكافي ١ : ١٩٠.
(٣) الكافي ١ : ١٩١.
(٤) جاء هذا الحديث في بيان العلّامة في بحار الأنوار ٦١ : ٢٣٥.
طينة آدم بيدي أربعين صباحا(١) .
وقال :( لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَ ) (٢) فبالأوّل وعد المطيعين بالجنّة، وبالثاني أوعد العاصين بالنار.
وتقديم البشارة لسبق رحمته على غضبه، وكذا الكلام في قوله تعالى :( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً * وَداعِياً إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِراجاً مُنِيراً ) (٣) .
( لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ) تعليل لإرساله تعالى له صلّى الله عليه وآله، فإن قرئ الأفعال الأربعة بالغيبة ـ كما عن ابن كثير وأبي عمرو ـ فلا إشكال، إلّا أنّه وقع الالتفات في «بالله ورسوله» من الخطاب إلى الغيبة ؛ إذ الأصل في نحو هذا المقام أن يقال ليؤمنوا بي وبك.
وأمّا على القراءة المشهورة من تاء الخطاب، فعلى تقدير القول في المعلّل فلا إشكال أيضا ؛ إذ المعنى ؛ قل لهم : إنّا أرسلناك لتؤمنوا بالله ورسوله.
وكذا لو لم نقدّره، ولكن جعلنا الخطاب للامّة خاصّة، إلّا أنّ فيه من الالتفات ما لا يخفى.
وكذا لو عمّم الخطاب وأزيد التغليب.
__________________
(١) عوالي اللئالي ٤ : ٩٨.
(٢) ص : ٧٥.
(٣) الأحزاب : ٤٥ و ٤٦.
وأمّا لو خصّ بالنبيّ صلّى الله عليه وآله ففيه إنّه إذا كان هو المرسل، فكيف يقال له لتؤمن بنفسك ويمكن التفصّي عنه بتوجيه الخطاب في «أرسلناك» إلى الهيكل المقدّس البشريّ وإرادة الحقيقة المجرّدة الأوّلية من رسوله؟ ولذا يصحّ شهادته برسالة نفسه في التشهّد والسلام على ذاته في التسليم.
و «التعزير» بالزاء المعجمة والراء المهملة : التفخيم والتعظيم والإعانة ؛ كما في قوله في سورة الأعراف :( فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) (١) وقرئ بالزاءين المعجمتين من العزّة وهي القوّة ؛ أي تقوّوه بنصركم إيّاه.
و «التوقير» التعظيم.
و «التسبيح» التنزيه عمّا لا يليق، والضمائر يحتمل أن تكون كلّها لله، وأن تكون كلّها لرسوله، وأن يكون الأخير للأوّل،والأوّلان للثاني،ولذا وقف بعضهم على «توقّره».
و «البكرة» الغدوّ.
و «الأصيل» العشيّ، ويمكن أن يراد بذلك الدوام إلّا أن يراد بالتسبيح : الصلاة، لا مطلق التنزيه.
وفي الآية دلالة على فساد قول من زعم أنّ الله يريد من الكافر الكفر، كما يريد من المؤمن الإيمان، فكلا الفريقين مجبور على ذلك لا يمكنه التخلّف ؛ إذ يلغو جعل الغرض من الإرسال هو إيمان الكفّار لو كانوا مجبورين على الكفر.
__________________
(١) الأعراف : ١٥٧.
وفي الآية أيضا إشارة إلى أنّ الإيمان الّذي هو غاية إرسال الرسل جوهر فوق الجواهر وأعلاها وأبهاها وأغلاها، فإنّه جوهر لا تذيبه النار، ولا يغرقه الماء، ولا يكسره آلة من الآلات، فلا يضرّ المؤمن فقد الجواهر المعدنيّة وعدم الزخارف الدنيويّة، وهذه الجواهر ما ضرّ واجدها لو كان عادم طنّين وحراء، والسرّ في ذلك أن عظمة المقدّمة دالّة على أعظميّة ذيّها(١) .
( إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللهَ ) قد عرفت أنّ حقيقته المقدّسة في الأسماء التكوينيّة بمنزلة اسم الله في الأسماء التدوينيّة، فقد جعله الله بمنزلة نفسه في جميع الأمور ؛ كما قال :( مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ ) (٢) ومنها : المبايعة والمعاهدة على أحكام الإسلام ونصرة الرسول في جميع الأيّام والأعوام.
وفي رواية عبد السلام المرويّة في العيون قال : قلت لعليّ بن موسى الرضا عليه السلام : يا ابن رسول الله صلّى الله عليه وآله ما تقول في الحديث الّذي يرويه أهل الحديث، إنّ المؤمنين يزورون ربّهم من منازلهم في الجنّة؟ فقال : يا أبا الصلت، إنّ الله فضّل نبيّه محمّدا صلّى الله عليه وآله على جميع خلقه من النبيّين والملائكة، وجعل طاعته طاعته، ومبايعته مبايعته، وزيارته في الدنيا والآخرة زيارته، فقال :( مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ ) وقال :( إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ) (٣) وقال النبيّ
__________________
(١) العبارة في النسختين غير واضحة. والاضطراب واضح فيها.
(٢) النساء : ٨٠.
(٣) الفتح : ١٠.
صلّى الله عليه وآله : من زارني في حياتي أو بعد موتي فقد زار الله، ودرجة النبيّ صلّى الله عليه وآله في الجنّة أرفع الدرجات، فمن زاره إلى درجته في الجنّة من منزله فقد زار الله(١) إلى آخره. انتهى.
( يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ) (٢) الجملة : إمّا تأكيد للمعنى المستفاد من الجملة السابقة، فإنّ يد الرسول صلّى الله عليه وآله كانت عند المبايعة فوق أيدي المبايعين، فجعل يده بمنزلة يده ؛ بل الرسول هو يد الله، لأنّه الموصل لفيض الله إلى عباده. ولذا قال وصيّه عليه السلام : أنا يد الله(٣) . وإلّا فلا يوصف الله بالجوارح وبصفات الأجسام.
قال محمّد بن مسلم : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إنّ الله عزّ وجلّ خلقا خلقهم من نوره، ورحمة من رحمته لرحمته، فهم عين الله الناظرة، وأذنه السامعة، ولسانه الناطق في خلقه بإذنه(٤) إلى آخره.
وإمّا بيان لكمال قدرة الله وقوّته، أو لكمال نعمة الله على خلقه.
وفي معاني الأخبار عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام فقلت : قوله عزّ وجلّ :( يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَ ) (٥) فقال : اليد في كلام العرب : القوّة والنعمة، قال الله :( وَاذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا
__________________
(١) بحار الأنوار ٤ : ٣، الأمالي، للصدوق : ٤٦٠، التوحيد : ١١٧، عيون أخبار الرضا عليه السلام ١ : ١١٥.
(٢) الفتح : ١٠.
(٣) الكافي ١ : ١٤٥.
(٤) بحار الأنوار ٢٦ : ٢٤٠، التوحيد : ١٦٧، معاني الأخبار : ١٦.
(٥) ص : ٧٥.
الْأَيْدِ ) (١) وقال :( وَالسَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ ) (٢) ؛ أي بقوّة(٣) إلى آخره.
وعن المشرقيّ عن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول :( بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ ) (٤) فقلت له : يدان هكذا ـ وأشرت بيدي إلى يديه ـ؟ فقال : لا، لو كان هكذا لكان مخلوقا(٥) . انتهى.
( فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ) وهذا يجري مجرى قوله تعالى :( إِنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ) (٦) . و «النكث» بالكسر : نقض العهد، وهو الغدر الّذي هو من جنود الجهل ؛ كما أنّ الوفاء به من جنود العقل، والأخبار في ذمّ الأوّل ومدح الثاني متكاثرة.
وفي بعضها : ألا وأنّ الغدر والفجور والخيانة في النار(٧) .
وفي بعضها : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليف إذا وعد(٨) .
وفي بعضها : عدة المؤمن أخاه نذر لا كفّارة له، فمن أخلف فبخلف الله بدأ ولمقته تعرّض(٩) إلى آخره. وحسبك في ذلك حكم العقل القاطع.
__________________
(١) ص : ١٧.
(٢) الذاريات : ٤٧.
(٣) بحار الأنوار ٤ : ٤، معاني الأخبار : ١٦.
(٤) المائدة : ٦٤.
(٥) بحار الأنوار ٣ : ٢٩١، معاني الأخبار : ١٨.
(٦) الزمر : ٤١.
(٧) الكافي ٢ : ٣٣٨.
(٨) الكافي ٢ : ٣٦٤.
(٩) الكافي ٢ : ٣٦٣.
و «العهد» في الآية يشمل عهد الله مع عباده في الذرّ ؛ كما قال :( أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ ) (١) إلى آخره. فمن وفي بهذا العهد فاز بالأجر العظيم وجنّات النعيم، ومن نقضه يرجع(٢) ضرره إلى نفسه، فإنّه يحرم عن المثوبات العظيمة، وعن مرافقة الأبرار، ويستحقّ عذاب النار.
وقرأ حفص بضمّ الهاء من «عليه» لمكان تفخيم الجلالة، ولكن الأولى قراءته بالكسر ؛ كما هو الأصل.
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم القمّيّ رحمه الله : إنّ الآية نزلت في بيعة الرضوان( لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ) (٣) واشترط عليهم أن لا ينكروا بعد ذلك على رسول الله صلّى الله عليه وآله شيئا يفعله، ولا يخالفوه في شيء يأمرهم به، فقال الله عزّ وجلّ بعد نزول آية الرضوان :( إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ ) (٤) إلى آخره. إنّما رضي الله عنهم بهذا الشرط(٥) . إلى آخر ما ذكره.
وحاصله يرجع إلى أنّ آية( إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ ) نزلت مؤخّرة عن آية الرضوان، فوقع الاشتباه في تأليف الآيات من عثمان ؛ فلا تغفل.
( سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرابِ شَغَلَتْنا أَمْوالُنا وَأَهْلُونا فَاسْتَغْفِرْ لَنا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً إِنْ أَرادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ
__________________
(١) يس : ٦٠.
(٢) «أ» : رجع.
(٣) الفتح : ١٨.
(٤) الفتح : ١٠.
(٥) تفسير القمّيّ ٢ : ٣١٥.
أَرادَ بِكُمْ نَفْعاً بَلْ كانَ اللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً ) إخبار عن الغيب، فإنّ هذا القول قد قيل بعد نزول هذه الآية، فإنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله لمـــّـا أراد المسير إلى مكّة عام الحديبيّة للحجّ والعمرة ـ وكان ذلك في سنة السّت من هجرته منها ـ طلب أن ينفر معه الأعراب الساكنون حول المدينة من القبائل المتفرّقة، فتخلّف منهم قبائل كأسلم وجهينة ومزينة وغفّار ؛ زعما منهم أنّ النبيّ وأصحابه لا يقدرون على مقاتلة قريش لكثرة عددهم وعدّتهم، فاعتذروا بأنّ الأوان أوان شغلهم بأموالهم وأهليهم، وأنّه ليس لهم من يقوم بإصلاح أمورهم وتنظيم أشغالهم، وظنّوا أنّ تخلّفهم يدفع عنهم الضرّ أو يعجّل لهم النفع بالسلامة في أنفسهم وأموالهم وأهليهم، وأنّ النبيّ وأصحابه لا يفلت أحد منهم من أيدي قريش، وقالوا : استغفر لنا من الله في هذا التخلّف عن الخروج والقعود عن النفر، وإنّما قالوا ذلك نفاقا، وتخلّفوا عن المؤمنين خوفا من غلبة قريش عليهم، وحذرا من القتل والاستئصال.
و «المخلّفون» بتشديد اللام المفتوحة، المتروكون في المدينة خلف الخارجين منها، يقال : خلّفه إذا تركه خلفه، فتخلّف ؛ أي قعد عن الخروج، وفي العدول عن لفظ التخلّف إلى التخليف مع أنّهم كانوا متخلّفين إشارة إلى أنّهم لمـــّـا تخلّفوا عن المؤمنين خذلهم الله وتركهم في ظلمات النفاق، فكانوا مخلّفين بعد أن صاروا متخلّفين.
و «الأعراب» اسم جمع للجماعة من عرب البادية خاصّة، وقد قال في حقّهم :( الْأَعْرابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفاقاً وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْزَلَ اللهُ ) (١) إلى آخره.
__________________
(١) التوبة : ٩٧.
والسرّ في نفاقهم، أنّهم لبعدهم عن حضرة الرسول وأصحابه العارفين بالأحكام، المطّلعين على المعجزات العظام، الواقفين على سيرة سيّد الأنام، لم يحصل لهم مقام اليقين الّذي هو حقيقة الإيمان الّذي هو روح الإسلام، ولذا كانوا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم كما هو حدّ(١) النفاق، وكانوا لا يعتقدون بأنّ الأمور كلّها تجري بأمر الله، وأنّ غيره لا يقدر على نفع ولا ضرر إلّا بإذن الله، وكانوا لا يتوكّلون في أمورهم على الله.
روى أبو بصير عن الصادق عليه السلام أنّه قال : ليس شيء إلّا وله حدّ. قال : قلت : جعلت فداك، فما حدّ التوكّل؟ قال : اليقين، قلت : فما حدّ اليقين؟ قال : أن لا تخاف مع الله شيئا(٢) .
وفي رواية زرارة عنه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام على المنبر : لا يجد أحدكم طعم الإيمان حتّى يعلم أنّ ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه(٣) .
ونحوها رواية صفوان الجمّال، ولكن بزيادة : وأنّ الضارّ النافع هو الله(٤) .
وفي رواية ابن أسباط : ومن أيقن بالقدر علم أنّ ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فلم يحزن على ما فاته، ولم يخش إلّا الله(٥) . انتهى.
ومن دلائل نفاقهم اعتذارهم بما يدلّ على أنّ اهتمامهم بدنياهم كان
__________________
(١) أي تعريف النفاق.
(٢) الكافي ٢ : ٥٧.
(٣) الكافي ٢ : ٥٨.
(٤) الكافي ٢ : ٥٨.
(٥) الكافي ٢ : ٥٩.
أشدّ من اهتمامهم بأمر آخرتهم ودينهم، وقد قال الله :( قُلْ إِنْ كانَ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ وَإِخْوانُكُمْ وَأَزْواجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوالٌ اقْتَرَفْتُمُوها وَتِجارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسادَها وَمَساكِنُ تَرْضَوْنَها أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ ) (١) وقال :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ فَما مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ) (٢) .
ويمكن قراءة «المخلّفون» بتخفيف اللام ؛ أي الّذين أخلفوا ما عاهدوا الله عليه، إلّا أنّي لم أجد من قرأ بها.
وكيف كان، فاعتذار المخلّفين أو المخلفين أعظم وأشدّ من ذنبهم، فإنّه راجع إلى أنّ أموالهم وأهليهم أحبّ إليهم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، والإخلال بشرط الإيمان وهي محبّة الله ورسوله لكونه إخلالا بأصول الدين أعظم ذنبا من إخلالهم بالجهاد الّذي هو من فروع الدين، مع أنّ في طلبهم العفو والغفران مع عدم إذعانهم بكون ما صدر عنهم ذنبا لكونهم منافقين، وأنّ ما يقولون بألسنتهم من الشهادة بالتوحيد والرسالة ليس ممّا يعتقدونه بقلوبهم، نوع استهزاء برسول الله وتجهيل له، باعتقادهم أنّه لا يعلم بواطن أمورهم، ولا يطلعه الله على سرائر قلوبهم بالوحي إليه، كما قال :( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ * يُخادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَما يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَما يَشْعُرُونَ ) إلى قوله تعالى( وَإِذا لَقُوا الَّذِينَ
__________________
(١) التوبة : ٢٤.
(٢) التوبة : ٣٨.
آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ * اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ ) (١) .
وهذا الاستهزاء لا يطّلع عليه سوى الخبير بالبواطن، لكونه أمرا قلبيّا، ولذا قال :( بَلْ كانَ اللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً ) (٢) .
وفي التعبير بـ «بل» ردّ على ما زعموه من أنّ ما أضمروه من النفاق والاستهزاء لا يطّلع عليه أحد، وفي سورة التوبة :( يَحْذَرُ الْمُنافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِما فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِؤُا إِنَّ اللهَ مُخْرِجٌ ما تَحْذَرُونَ * وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ ) (٣) .
وقوله تعالى :( بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلى أَهْلِيهِمْ أَبَداً وَزُيِّنَ ذلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْماً بُوراً ) (٤) بدل أو عطف بيان لقوله( بَلْ كانَ اللهُ بِما تَعْمَلُونَ ) (٥) وفيه تفصيل لما أجمل، وتوضيح لما أبهم، وقد يقال : إنّ «بل» في الموضعين للانتقال من غرض إلى آخر، وما ذكرناه أظهر، ففيه ردّ على ما ذكروه من انحصار عذرهم بشغل الأموال والأهل ؛ مع أنّ عذرهم في الباطن هو ظنّهم بأنّ قريشا يستأصلون محمّدا وأصحابه ويصطلمونهم ؛ فلا يرجعون إلى من خلفهم في المدينة من الأهل والأولاد أبدا.
__________________
(١) البقرة : ٨ ـ ١٥.
(٢) الفتح : ١١.
(٣) التوبة : ٦٤ و ٦٥.
(٤) الفتح : ١٢.
(٥) الفتح : ١١.
وهذا هو ظنّ السوء الّذي ظنّوه برسول الله صلّى الله عليه وآله وأصحابه ؛ حيث ظنّوا هلاكهم لقلّة عددهم وعدّتهم بخلاف أعدائهم ومعانديهم من قريش ومعاونيهم من سائر القبائل، وقد زيّن الشيطان ذلك في قلوبهم ولم يعلموا أنّ النصر بيد الله :( كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ ) (١) .
و «الأهلون» جمع الأهل، ولكنّه على خلاف القياس، فإنّ من شرط هذا الجمع أن يكون مفرده علما أو وصفا، وليس «الأهل» بشيء منهما، فإنّه يطلق على من يجمع الشخص وإيّاهم مسكن واحد، أو نسب واحد، أو دين واحد، أو نحو ذلك.
وقد يجمع على «أهلات» بسكون الهاء وفتحها، ولكن قد يقال : إنّهما(٢) جمعا «أهلة» بالتاء، وعلى «آهال» كأفراخ ؛ قال الشاعر :
وبلدة ما الأنس من آهالها
وعلى «الأهالي» بزيادة الياء على خلاف القياس ؛ كالليالي في الليل، ولكن في «الأنوار» إنّه اسم جمع كليال.
و «البور» بضمّ الباء ؛ في الأصل مصدر، لا يثنّى ولا يجمع، ومعناه : الفساد والهلاك، والمراد به هنا الهلكى، وصفوا به من باب المبالغة ؛ كما في قولهم : زيد عدل. قال الشاعر :
يا رسول المليك إنّ لساني |
راتق ما فتقت إذ أنا بور |
أي : فاسد، هالك، وفيه شهادة على فساد ما قيل من أنّه جمع «بائر»
__________________
(١) البقرة : ٢٤٩.
(٢) أي كلمة «الأهلون» و «أهلات».
ك «حول»(١) في «حائل».
وفي الصحاح : رجل حائر بائر : إذا لم يتّجه لشيء(٢) . وهو اتّباع لحائر. ويظهر منه أنّ البور هو الرجل الفاسد الهالك الّذي لا خير فيه، فلا يكون مصدرا. فافهم.
وإنّما كانوا هلكى، لفساد عقيدتهم وضعف إيمانهم من أوّل الأمر، والمراد بهلاكهم، هو ضلالتهم عن طريق الحقّ ومتابعة الهدى.
ويقال للضالّ في المفازة : الهالك ؛ لأنّ مآله إلى الهلاك غالبا. ولذا يقال لها : المهلكة أيضا، وإطلاق المفازة للتفأّل بالخير، أو انتفاء روح الإيمان وزهوقه عنهم.
وفي الحديث : إنّ الأرواح خمسة : روح القدس، وروح الإيمان، وروح القوّة، وروح الشهوة، وروح البدن ؛ فمن الناس من يجتمع فيه الخمسة الأرواح ؛ وهم الأنبياء السابقون، ومنهم من يجتمع فيهم أربعة أرواح ؛ وهم ممّن عداهم من المؤمنين، ومنهم من يجتمع فيه ثلاثة أرواح ؛ وهم اليهود والنصارى ومن يحذو حذوهم(٣) .
وفي رواية : وأمّا ما ذكرت من أصحاب الميمنة فهم المؤمنون حقّا جعل فيهم أربعة أرواح : روح الإيمان، وروح القوّة، وروح الشهوة، وروح البدن، ولا يزال العبد مستكملا بهذه الأرواح الأربعة حتّى يهمّ بالخطيئة، فإذا همّ
__________________
(١) «أ» : جمع.
(٢) صحاح اللغة ٢ : ٦٤١ (حير).
(٣) بحار الأنوار ٢٥ : ٥٤. لكن يختلف في بعض عباراته.
بالخطيئة تزيّن له روح الشهوة، وشجّعه روح القوّة، وقاده روح البدن حتّى يوقعه في تلك الخطيئة، فإذا لامس الخطيئة انتقص من الإيمان وانتقص الإيمان منه، فإن تاب تاب الله عليه.
إلى أن قال : وأمّا ما ذكرت من أصحاب المشأمة فمنهم أهل الكتاب، قال الله تبارك وتعالى :( الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ * الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ) (١) عرفوا رسول الله والوصيّ من بعده وكتموا ما عرفوا من الحقّ بغيا وحسدا، فسلبهم روح الإيمان، وجعل لهم ثلاثة أرواح : روح القوّة، وروح الشهوة وروح البدن، ثمّ أضافهم إلى الأنعام فقال :( إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً ) (٢) لأنّ الدابّة إنّما تحمل بروح القوّة، وتعتلف بروح الشهوة، وتسير بروح البدن(٣) . انتهى.
ولعلّ في التعبير بلفظ الماضي إشارة إلى أنّ الله قد علم في الأزل بكفرهم وضلالتهم فوقع على هذا قضاؤه السابق، فحقّ عليهم كلمة العذاب ؛ كما قال :( وَكَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحابُ النَّارِ ) (٤) وقال :( لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ) (٥) .
( وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ سَعِيراً ) يحتمل أن يكون
__________________
(١) البقرة : ١٤٦ و ١٤٧.
(٢) الفرقان : ٤٤.
(٣) بحار الأنوار ٦٩ : ١٩١.
(٤) غافر : ٦.
(٥) يس : ٧.
عطفا على قوله :( الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ ) إلى آخره فإنّه تعالى لمـــّـا أشار إلى أنّ الغرض الأصليّ من إرساله صلّى الله عليه وآله الإيمان بالله ورسوله وتعظيم دينه والتنزيه عمّا لا يليق، مدح المؤمنين أوّلا ثمّ أتبعه بذمّ المنافقين، ثمّ بذمّ الكافرين جهارا، وإنّما وسّط المنافقين لكونهم مذبذبين بين ذلك ؛ لا إلى هؤلاء، ولا إلى هؤلاء ؛ أي ليسوا بمؤمنين بحسب الواقع، ولا بكافرين بحسب الظاهر.
ويحتمل أن يكون المراد بالكافرين هم المنافقين المتقدّم ذكرهم، أو ما يشملهم، وفي وضع الظاهر موضع الضمير تعريض بأنّ المنافق أيضا من أصناف الكفّار يعامل الله معه معاملتهم من إدخاله السعير الّتي أعدّها لهم، فالرابط بين الشرط والجزاء هو العموم، وفيه أيضا إشعار بأنّ العلّة للجزاء المذكور هو الكفر.
و «الاعتداد» هو الإعداد الّذي معناه التهيئة ؛ كما في قوله تعالى :( وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً ) (١) ؛ أي أعدّت وهيّأت. والعتاد : العدّة والأهبة.
و «سعير» اسم من أسماء جهنّم ـ على ما قيل ـ ولكن يرده التنوين، فإنّه لا يلحق غير المنصرف للعلميّة والتّأنيث كغيرهما من أسباب المنع، فالأولى كونه وصفا للنار ؛ أي : نارا موقدة.
والتنكير، للتهويل والتعظيم ؛ كما في قوله تعالى :( فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ) (٢) أي : بحرب عظيم، أو للنوعيّة ؛ أي : نوعا مخصوصا من النار.
__________________
(١) يوسف : ٣١.
(٢) البقرة : ٢٧٩.
وروي عن ابن عبّاس في قوله تعالى :( وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ) (١) قال : يريد أو قدت للكافرين(٢) .
و «الجحيم» : النار الأعلى من جهنّم، والجحيم في كلام العرب أعظم من النار.
وفي سورة الفرقان :( بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيراً * إِذا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَها تَغَيُّظاً وَزَفِيراً * وَإِذا أُلْقُوا مِنْها مَكاناً ضَيِّقاً مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنالِكَ ثُبُوراً ) (٣) وقد فسّرت السعير في هذه الآية بالنار الشديدة الإسعار.
( وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً ) .
«الملك» بالضمّ : السلطنة والقدرة.
وقيل : هو عبارة عن القدرة الحسّيّة العامّة لما يملك شرعا ولما لا يملك.
وقيل : هو التسلّط على من يتأتّى منه الطاعة سواء كان بالاستحقاق أو بغيره.
وبالكسر : ما يكون بالاستحقاق.
وقيل : إنّه بالضمّ يعمّ التصرّف في ذوي العقول وغيرهم، وبالكسر : مختصّ بغيرهم.
و «الملك» بالفتح والكسر أدلّ على التعظيم من المالك، لأنّه أقدر على ما
__________________
(١) التكوير : ١٢.
(٢) تفسير القمّيّ ٢ : ٤٠٨.
(٣) الفرقان : ١١ ـ ١٣.
يريده في تصرّفاته، وأقوى تمكّنا واستيلاء من المالك.
وكيف [ما كان]، فالله تعالى هو المالك لجميع السماوات والأرض، وما فيهنّ وما بينهنّ بالاستحقاق، وهو الملك الّذي له ملك السماوات والأرض، وما فيهنّ وما بينهنّ بالاستحقاق يتصرّف فيهنّ، ويدبّر أمورهنّ بالعدل والحكمة.
وجمع «السماوات» لكونها كرات متعدّدة معروفة مع أنّ أجناسها مختلفة على ما يستفاد من بعض الأخبار، وأفرد الأرض لكونها كرة واحدة وإن تعدّدت طبقاتها.
وفي الآية إشارة إلى أنّه تعالى هو الملك الحقيقيّ، فإنّه إذا كان ملك السماوات والأرض له، فكلّ ملك من دونه فهو مقهور، تحت سلطنته، محتاج إليه في جميع ما يتقوّم به في ذاته وصفاته. كيف ووجود الكلّ منه، وهو تعالى غنيّ عمّا سواه في ذاته وصفته؟ كيف وهو واجب الوجود، وما عداه ممكن بذاته، مفتقر إليه في إفاضة الجود؟!
فلا يمكن أن يكون الملك المطلق غيره، فإنّ الملك الحقيقيّ هو الّذي استغنى عن غيره، واحتاج إليه غيره، وليس سوى الحقّ، فتعالى الله الملك الحقّ، المالك بالحقّ، المتصرّف في الملك والملكوت بالحقّ.
ألا كلّ شيء ما سوى الله باطل |
[وكلّ نعيم لا محالة زائل](١) |
|
آنكه در معرض فنا باشد |
لاف شاهى زند خطا باشد |
|
نيست جز حقّ به آشكار ونهان |
هيچ كس پادشاه پادشهان |
__________________
(١) الإلهيّات ١ : ٥٣ وفيه بدل كلمة «سوى» كلمة «خلا» وهو من قصيدة لبيد.
فإطلاق «الملك» و «ملك الملوك» على ملوك الدنيا مجازيّ ؛ نظير إطلاق الفرس على المنقوش على الجدار، ولذا يقول :( لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ ) (١) .
وقوله :( يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ ) إشارة إلى بعض تصرّفاته وسلطنته ؛ أي يعفو عن ذنوب من يشاء بفضله ؛ على وفق حكمته.
( وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ ) إذا عصى، بعدله ومصلحته.
وتفسير الأشاعرة بما يلزم الجبر وينافي العدل لا يصغى إليه.
وفي قوله :( وَكانَ اللهُ غَفُوراً ) إلى آخره إشارة إلى أنّ رحمته سابقة على غضبه، وأنّ الرحمة والغفران من صفات الذات، وأنّ العذاب داخل تحت قضائه بالعرض، فإنّ الغرض الأصليّ من الخلق كان هو الرحمة ؛ كما قال :( وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ ) (٢) لا التعذيب، ولذا قال : إنّ رحمتي سبقت غضبي(٣) .
ويحتمل أن يكون وصفه بـ «غفورا» ناظرا إلى قوله :( يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ ) يعني يغفر كثيرا من الذنوب لكثير من المذنبين، وب «رحيما» ناظرا إلى قوله :( وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ ) يعني يرحمهم ويعفو عمّن يعذّبه في آخر الأمر إذا لم يستحقّ الخلود.
ويمكن أن يكون إشارة إلى أنّ التعذيب أيضا من مقتضى رحمته، فإنّ فيه إصلاحا لحاله، وتطهيرا لقلبه من أو ساخ الذنوب، ليأهل لمرافقة الأبرار في دار القرار.
__________________
(١) غافر : ١٦.
(٢) هود : ١١٩.
(٣) الكافي ٢ : ٢٧٤.
وفي رواية عمر بن أبان عن الصادق عليه السلام قال : إنّ أناسا يخرجون من النار بعد ما كانوا حمما فينطلق بهم إلى نهر عند باب الجنّة يقال له «الحيوان» فينضح عليهم من مائه فتنبت لحومهم ودماؤهم وشعورهم(١) . وقريب منها روايات أخر.
قال القيصريّ في شرح الفصوص : اعلم أنّ من اكتحلت عينه بنور الحقّ يعلم أنّ العالم بأسره عباد الله، وليس له وجود وصفة إلّا بالله وحوله وقوّته، وكلّهم محتاجون إلى رحمته، وهو الرحمان الرحيم، ومن شأن من هو موصوف بهذه الصفات أن لا يعذّب أحدا عذابا أبديّا، وليس ذلك المقدار من العذاب إلّا لأجل إيصالهم إلى كمالاتهم المعدودة كما يذاب الذهب والفضّة بالنار لأجل الخلاص ممّا يكدّره وينقص عياره، وهو يتضمّن اللطف والرحمة ؛ كما قيل :
وتعذيبكم عذب وسخطكم رضى |
وقطعكم وصل وجوركم عدل |
أقول : ما زعمه من نفي الخلود مسلّم بالنسبة إلى أهل التوحيد الّذين أقرّوا به مع شرطه وشروطه الّتي منها الإذعان بمراتب الأئمّة الاثني عشر عليهم السلام والتديّن بموالاتهم لا مطلقا، فإنّه مخالف للضرورة الدينيّة المستفادة من الآيات والأخبار المتواترة القطعيّة، فما ذكره تبعا لشيخه الأعرابيّ لا يصغي إليه المسلم كاستدلاله بما روي ضعيفا من طرق العامّة من
__________________
(١) بحار الأنوار ٨ : ٣٦١.
أنّه يأتي على جهنّم زمان ينبت في قعرها الجرجر(١) ، فإنّه لا يعارض ما أشرنا إليه من الآيات والأخبار.
وأمّا ما قيل من أنّ الثناء بصدق الوعد لا بصدق الوعيد، بل بالتجاوز :( فَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ) (٢) ولم يقل وعيده، بل قال :( وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئاتِ ) (٣) فهو كما ترى.
وقول ابن مسعود : ليأتينّ على جهنّم زمان ليس فيها أحد، وذلك بعد ما يلبثون أحقابا. ليس بحجّة. فافهم، ولا تغترّ بوساوس الشيطان، وقد قال :( لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ) (٤) .
( سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلى مَغانِمَ لِتَأْخُذُوها ذَرُونا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونا كَذلِكُمْ قالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ كانُوا لا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلاً ) هذا أيضا إخبار عن الغيب، لعدم وقوع هذا القول، بل نزول هذه الآية.
وقد روي أنّهم لمـــّـا انصرفوا من الحديبيّة بالصلح وعدهم الله فتح خيبر، وخصّ بغنائمها من شهد الحديبيّة، ولم يتخلّف عن رسول الله صلّى الله عليه وآله عند مسيره إليها، فلمّا أرادوا المسير إلى خيبر قال : هؤلاء المخلّفون(٥) : ذرونا ـ أي اتركونا ـ نتّبعكم ؛ أي نجيء معكم لنصرتكم. ولا
__________________
(١) الجرجر والجرجير : بقلة معروفة.
(٢) إبراهيم : ٤٧.
(٣) الشورى : ٢٥.
(٤) ص : ٨٢ و ٨٣.
(٥) «ب» : المتخلّفون.
ماضي لـ «ذر» كـ «دع» و «هب» بمعنى احسب، إلّا أنّ «هب» هذه من الجوامد المطلقة ؛ كـ «نعم» و «بئس» في الماضي.
وإنّما قالوا ذلك لتكذيب وعد الله المغانم في خيبر للسائرين إلى الحديبيّة خاصّة ؛ لا يشركهم فيها غيرهم. وهذا هو المراد بكلام الله.
وعن الجبّائيّ : إنّ المراد به قوله تعالى لهم حين تثبّطوا عن الخروج إلى تبوك :( فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَلَنْ تُقاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ) (١) فأرادوا بالخروج تكذيب هذا الكلام.
قال شيخنا الطبرسيّ رحمه الله في مجمع البيان : وهذا غلط فاحش، لأنّ هذه السورة نزلت بعد الانصراف من الحديبيّة في سنة ستّ من الهجرة، وتلك الآية ـ أي قوله :( قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونا ) ـ نزلت في الّذين تخلّفوا عن تبوك.
وكانت غزوة تبوك بعد فتح مكّة وبعد غزوة حنين والطائف ورجوع النبي صلّى الله عليه وآله منها إلى المدينة ومقامه ما بين ذي الحجّة إلى رجب، ثمّ تهيّأ في رجب للخروج إلى تبوك، وكان منصرفه صلّى الله عليه وآله من تبوك في بقيّة رمضان من سنة تسع من الهجرة، ولم يخرج بعد ذلك لقتال ولا غزو إلى أن قبضه الله تعالى، فكيف تكون هذه الآية مرادة بقوله( كَلامَ اللهِ ) وقد نزلت بعده بأربع سنين(٢) ؟ انتهى.
و «كم» في «كذلكم» حرف الخطاب، وإنّما جمع لتعدّد المخاطب بهذا الخطاب، وأفرد الإشارة لأنّ المشار إليه الوعد المذكور، وهو أمر واحد،
__________________
(١) التوبة : ٨٣.
(٢) مجمع البيان ٥ : ١١٤.
وتفصيل باب المخاطبة في النحو، وقد ذكره ابن مالك في التسهيل فراجع.
وقولهم( بَلْ تَحْسُدُونَنا ) ردّ على المؤمنين وتكذيب لهم في قولهم : إنّ الله وعدنا خاصّة غنيمة خيبر، وهذا راجع إلى تكذيب الرسول في وحيه، وقوله تعالى :( بَلْ كانُوا ) ردّ على المنافقين في اعتقادهم أنّ منعهم عن النفر للحسد، وأنّ قولهم ذلك لعدم شعورهم، وقوله :( إِلَّا قَلِيلاً ) ؛ أي إلّا فقها قليلا، فيكون وصفا للمصدر المحذوف أو القليل منهم، فيكون مستثنى من ضمير الجمع ؛ كما في قوله تعالى :( ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ ) (١) فيجوز فيه الرفع على البدليّة، والنصب على الاستثناء.
و «الفقه القليل» على الأوّل هو الشعور الحيوانيّ الّذي هو إدراك اللذّات والآلام الحسّيّة، فإنّه قليل بالنسبة إلى الإدراكات العقليّة الروحانيّة الخاصّة بالأناسيّ الإلهيّين، والإخوان الروحانيّين، وعلى الثاني هو من تاب منهم فأحسن عقيدته، وآمن بقلبه كما آمن بلسانه، وهو قليل في هؤلاء المخلّفين ؛ كما قال :( وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ ) (٢) .
ويحتمل أن يراد به من عرف الحقّ بقلبه ولكن أنكره من باب العناد، والعصبيّة، وحقد الجاهليّة، وحب الرئاسة، فافهم.
وفي الآية دلالة واضحة على أنّ المنافقين ليسوا بمؤمنين، بل أولئك هم الكافرون حقّا.
( قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرابِ سَتُدْعَوْنَ إِلى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقاتِلُونَهُمْ أَوْ
__________________
(١) النساء : ٦٦.
(٢) سبأ : ١٣.
يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللهُ أَجْراً حَسَناً وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَما تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً ) لم يقنطهم الله من رحمته مع ما شدّد عليهم من النكير وأوعدهم بالسعير، فإنّ بابه مفتوح لكلّ من أتاه، وفضله متاح لكلّ عبد وإن عصاه، كيف وقد قال :( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ ) (١) فالتوبة هو باب الأبواب.
وقال :( يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ) (٢) بل وعدهم الأجر الحسن لو رجعوا إلى الطاعة، فإنّ التائب من الذنب كمن لا ذنب له(٣) .
وفيه أيضا إخبار عن الغيب، فإنّ جماعة منهم اتّبعوا المؤمنين في قتال هوازن وغيرهم من القبائل، ولا ينافي ذلك قوله فيما تقدّم :( قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونا ) الدالّ على نفي الأبد، فإنّ المراد به المتابعة في غزوة خيبر خاصّة ؛ كما عرفته.
و( سَتُدْعَوْنَ ) ؛ أي : يدعوكم النّبيّ إلى قتال.
و «البأس» : الشدّة في الحرب.
ويطلق على العذاب أيضا ؛ كما قال :( فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا ) (٤) أي عذابنا.
( تُقاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ) ؛ أي يقع أحد الأمرين : إمّا المقاتلة، وإمّا الإسلام.
والمراد به إمّا الإقرار بالشهادتين، أو الانقياد للأمر والصلح ولو بإعطاء الجزية.
__________________
(١) طه : ٨٢.
(٢) الزمر : ٥٣.
(٣) انظر : الكافي ٢ : ٤٣٥.
(٤) غافر : ٨٤.
وفي قراءة «أبيّ» حذف النون فـ «إن» مقدّرة و «أو» بمعنى «إلى» فيكون الإسلام غاية للقتال.
والمراد بالتولّي هنا الإعراض والقعود عن القتال، والإحجام عنه.
( لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ) هذه الجملة بمنزلة الاستثناء عن المأمورين بالجهاد.
و «الحرج» : الضيق ؛ أي ليس على هؤلاء ضيق ومعصية في القعود عن الجهاد، فإنّ الله يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر.
وإنّما كرّر الحرج تأكيدا لبيان لطفه وشفقته على العباد ؛ كما أنّ قوله :
( وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذاباً أَلِيماً ) توكيد لما سبق من الوعد والوعيد، إلّا أنّ ما تقدّم خاصّ وما هنا عامّ، وإنّما فصّل الأوّل لسبق رحمته وكونه أدخل في الترغيب.
( لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً * وَمَغانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَها وَكانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً ) قد عرفت معنى رضا الله وسخطه، والمراد من السكينة.
واللام في «المؤمنين» للعهد ـ وكان عددهم ألفا وخمسمائة أو ثلاثمائة أو أربعمائة ـ كـ «اللام» في الشجرة ؛ وهي شجرة [السدر، أو](١) الطلح ؛ وهو الموز، وهو(٢) شجر حسن اللون له نور، طيّب، ولكنّه كثير الشوك.
روي أنّه لمـــّـا نزل رسول الله صلّى الله عليه وآله الحديبيّة بعث جراس بن
__________________
(١) ليس في «أ».
(٢) «أ» : فهو.
أميّة الخزاعيّ إلى أهل مكّة فهمّوا بقتله فرجع، فبعث عثمان بن عفّان فحبسوه فدعا رسول الله أصحابه وكان جالسا تحت هذه الشجرة وبايعهم على أن يقاتلوا قريشا ولا يفرّوا عنهم.
و «أثابهم» أي جازاهم ؛ من الثواب، وهو الجزاء على العمل، وهو في الأصل : الرجوع، فالعمل يرجع جزاؤه وخاصّيّته إلى العامل ؛ كما قال :( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ) (١) فالثواب أعمّ من جزاء الخير والشرّ، ولكن غلب استعماله في الأوّل.
والفتح القريب هو فتح خيبر، والمغانم الكثيرة هي مغانمها.
ومن المحتمل أن يكون المراد بها الدرجات العاليات الأخرويّة الّتي يستحقّونها بجهادهم في سبيل الله، هذا مع أنّ رضا الله عنهم أعلى مقاصد المؤمنين، بل المؤمن الكامل لا يطلب سوى رضاه، ولا يهتمّ بالغنائم الفانية الزائلة. ولذا سمّيت هذه البيعة ببيعة الرضوان(٢) .
( وَعَدَكُمُ اللهُ مَغانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَها فَعَجَّلَ لَكُمْ هذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً ) .
في هذه الآية وعد للمؤمنين بكثير من المغانم غير هذه الغنيمة المعجّلة الّتي ستحصل لهم بخيبر، فإن كان الخطاب المشافهة كان المراد بها ما حصل لهم في عهد النبيّ صلّى الله عليه وآله وما بعده إلى زمن انقراضهم، فلا يشمل ما حصل للتابعين من الفتوح، وإلّا لشمل ما يحصل لهم من الفيء إلى يوم القيامة.
__________________
(١) الزلزلة : ٧ و ٨.
(٢) «ب» : بيعة الرضوان.
والمراد بكفّ الأيدي : حفظهم عن أذى الكفّار بما وقع من الصلح في الحديبيّة، أو عن خلفاء أهل خيبر من أسد وغطفان، فإنّه لمـــّـا حاصرها همّت قبائل من العرب أن يغيروا على أموال المسلمين وعيالاتهم بالمدينة، وهمّت اخرى أن ينصروا اليهود في خيبر، فقذف الله الرعب في قلوبهم فانصرفوا، وإنّما فعل ذلك ليحصل لهم الاستعداد لفتح مكّة وغيرها، ولتكون علامة لصدق النبيّ فيما وعد المؤمنين.
فقوله :( وَلِتَكُونَ آيَةً ) عطف على محذوف، هو علّة للتعجيل بالغنيمة أو كفّ الأذى ؛ أي عجّل أو كفّ أو فعل الأمرين لتستعدّوا ويحصل لكم كثرة العدد والعدّة، وليكون آية لهم، فإنّ غلبة النبيّ مع قلّة عدده وعدّته على هؤلاء القبائل الكثيرة الجمّة في مدّة يسيرة آية كاشفة عن صدقه في دعوى النبوّة.
وقوله :( وَيَهْدِيَكُمْ ) أي يزيدكم البصيرة في الدين، ويثبّتكم على الإيمان بالنبيّ، وإلّا فقد كانوا مؤمنين من قبل.
( وَأُخْرى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْها قَدْ أَحاطَ اللهُ بِها وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً ) ؛ أي عجّل لكم غير مغانم خيبر مغانم أخرى لم تقدروا عليها إلى الآن، بل وقع لكم فيها الانكسار والحولة ؛ أي الهزيمة، مثل مغانم هوازن في غزوة حنين.
فقوله :( وَأُخْرى ) وصف لـ «مغانم» وعطف على «هذه».
ويحتمل نصبها على التفسير، ورفعها على الابتداء، وإن كانت نكرة، لمكان الوصف بالجملة بعدها وجرّها بـ «ربّ» المحذوفة.
وقوله :( قَدْ أَحاطَ اللهُ ) إلى آخره. كناية عن إظفار الله لهم بهذه الغنائم باستيلائهم على أهلها.
قال الطبرسيّ رحمه الله : فجعلهم بمنزلة قوم قد أدير حولهم ؛ فما يقدر أحد منهم أن يفلت(١) .
( وَلَوْ قاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبارَ ثُمَّ لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً * سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً ) .
أراد بـ «الّذين كفروا» كفّار قريش الّذين كانوا بمكّة.
و «تولية الدبر» كناية عن الفرار والانهزام.
وقيل : المراد بالّذين كفرواهم الّذين همّوا بالإغارة على أموال المسلمين بالمدينة من أسد وغطفان.
ومحصّل الآية : أنّ الله كان ينصر المؤمنين على الكافرين لقدرته على نصر من ليس له عدد ولا عدّة، فإنّ الأمور كلّها بيد الله ؛ يذلّ من يشاء، ويعزّ من يشاء، ويخذل من يشاء، وينصر من يشاء، وهذه سنّة الله وطريقته القديمة الّتي سلفت في أنبيائه والمعاندين لهم، فإنّ حزب الله هم الغالبون.
ونصب «سنّة الله» بفعل محذوف ؛ أي سنّ سنّة الله.
( وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكانَ اللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيراً ) امتنّ الله عليهم بكفّ تعرّضهم للكفّار، وكفّ تعرّض الكفّار لهم بالأمر بالصلح، وإلقاء الرعب في قلوب الكفّار حتّى يرضوا به.
وقد روي أنّ ثمانين منهم طافوا بعسكر المسلمين ليصيبوا منهم،
__________________
(١) مجمع البيان، المجلّد ٥ : ١٨٦.
فأخذوا وأتي بهم إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله، فعفا عنهم وخلّى سبيلهم، فكان ذلك سبب الصلح.
والمراد بـ «بطن مكّة» هو الحديبيّة، فإنّها اسم لبئر قرب مكّة.
والمراد بـ «الإظفار» إمّا أخذهم الثمانين المشار إليهم، وإمّا نصرتهم في سائر الغزوات كبدر وأحد.
( هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِساءٌ مُؤْمِناتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً ) .
«الصدّ» : المنع بالعدوّ، ويقال لمن منعه العدوّ عن الحجّ المصدود ؛ كما يقال للممنوع عنه بالمرض ونحوه المحصور، وتفصيل أحكامهما في الفقه.
و «الهدي» عطف على الضمير المنصوب في «صدّوكم» ؛ أي منعوكم عن دخول المسجد، ومنعوا الهدي عن أن يبلغ مكانه الّذي كان ينحر فيه من الحرم، وهدي العمرة لا ينحر إلّا بمكّة ؛ كما أنّ هدي الحجّ لا ينحر إلّا بمنى.
ويحتمل كونه عطفا على «المسجد» فيكون «أن يبلغ» بدلا عنه بدل الاشتمال.
والمراد بـ «الهدي» : البدن الّتي ساقها رسول الله، وكانت سبعين بدنة، حتّى بلغ ذا الحليفة فقلّدها وأشعرها، وأحرم بالعمرة حتّى نزل بالحديبيّة، فمنعه المشركون، فنحرها بعد الصلح.
و «معكوفا» أي محبوسا.
والمراد بـ «الرجال» : المؤمنين.
و «النساء» : المؤمنات ؛ هم الّذين كانوا بمكّة مختفين عن المشركين، وكان المؤمنون لا يعرفونهم بأعيانهم، فلو قاتلوا أهل مكّة صار هؤلاء مقتولين.
فجواب «لو لا» في قوله :( وَلَوْ لا رِجالٌ ) إلى آخره. محذوف ؛ أي لأمركم بقتالهم.
و «المعرّة» : الإثم والجناية أو الدية.
واللام في «ليدخل» تعليل لعدم الإذن في قتالهم، وهو مستفاد من الكلام كما لا يخفى. ويرشد إليه أيضا قوله :( لَوْ تَزَيَّلُوا ) أي : لو تميّز المؤمن من الكافر بحسب الظاهر. فهذا الاختلاط أوجب دفع العذاب عن الكفّار.
وقد وردت أخبار كثيرة بأنّ الله يدفع بمؤمن واحد البلاء عن البلد.
ففي رواية الثماليّ : إنّ الله ليدفع بالمؤمن الواحد عن القرية : الفناء(١) .
وفي روايته الاخرى : لا يصيب قرية عذاب وفيها سبعة من المؤمنين(٢) .
وفي رواية يونس بن ظبيان عن الصادق عليه السلام قال : إنّ الله ليدفع بمن يصلّي من شيعتنا عمّن لا يصلّي من شيعتنا، ولو أجمعوا على ترك الصلاة لهلكوا، وإنّ الله ليدفع بمن يزكّي من شيعتنا عمّن لا يزكّي، ولو
__________________
(١) الكافي ٢ : ٢٤٧.
(٢) الكافي ٢ : ٢٤٧.
أجمعوا على ترك الزكاة لهلكوا(١) .
( إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى وَكانُوا أَحَقَّ بِها وَأَهْلَها وَكانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ) الظرف إمّا متعلّق بـ «عذّبنا» أو بـ «اذكر» أو بـ «أذنّا لكم في قتالهم».
والمراد بـ «حميّة الجاهليّة» : عدم الانقياد لأحد ؛ من التكبّر والنخوة، وقد قالوا : إنّ محمّدا قتل آباءنا وإخواننا، فكيف نتركه يدخل منازلنا، فتتحدّث العرب : إنّه دخل علينا على رغم أنفنا، فواللات والعزّى لا ندعه أن يدخل مكّة أبدا.
قال في الصحاح : وحميت عن كذا حميّة بالتشديد، ومحميّة : إذا أنفت منه وداخلك عار، وأنفة أن تفعله(٢) . انتهى.
وإنّما نسبت إلى الجاهلية لكونها سجيّة لآبائهم الجهلة الضالّين، فإنّ العالم العاقل مطيع(٣) من هو أعلم وأعقل منه.
والمراد بـ «كلمة التقوى» وإن فسّرت بـ «كلمة لا إله إلّا الله» إلّا أنّ المراد بها حقيقة التوحيد لا مجرّد التفوّه بهذه الحروف والأصوات ؛ كما يقال : «كلمة الحضرة» لـ «كلمة كن» في قوله :( إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) (٤) مع أنّ المراد هو نفس الإرادة الكلّيّة وتعلّقها بإيجاد الشيء،
__________________
(١) الكافي ٢ : ٤٥١.
(٢) صحاح اللغة ٦ : ٢٣٣٠ (حمي).
(٣) «أ» : يطيع.
(٤) النحل : ٤٠.
فكما أنّ كلمة «كن» صورة هذه الإرادة، فكذلك كلمة «التهليل» صورة التوحيد.
والمقصود هو حقيقته ومعناه، وإنّما نسبت إلى التقوى ؛ لأنّ المقرّ بالصانع وتوحيده بحقيقة الإقرار لا يخالف أمره، ولا يرتكب متعلّق نهيه.
والتقوى حقيقتها هي التورّع عن معاصي الله.
وبالجملة : «الكلمة» قد تطلق على كلّ واحدة من الماهيّات باعتبار وجودها في الخارج ويقال لها : «الكلمة الوجوديّة» ويطلق عليها بدون هذا الاعتبار «الحرف الغيبيّ» ويطلق على المجرّدات والمفارقات «الكلمة التامّة» ولتفصيل ذلك محلّ آخر.
وفسّرها بعضهم بالبسملة والإقرار بالرسالة.
والمراد بـ «إلزامهم هذه الكلمة» أنّهم لا يفارقونها، بل هم ثابتون على الإيمان لا ينكثون عهد الله ورسوله فيه، فهم أحقّ بهذه الكلمة، ومستأهلين لها.
وقيل : الضمير راجع إلى مكّة، لأنّهم أهل الله، فهم أحقّ ببلد فيه بيت الله.
( لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ فَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلِكَ فَتْحاً قَرِيباً ) اللام توطئة للقسم المحذوف، ووجه التوكيد بالقسم إنكار المنافقين صدق هذه الرؤيا، فإنّ الله لمـــّـا أرى نبيّه في المنام بالمدينة أنّ المسلمين دخلوا المسجد الحرام محلّقين ومقصّرين أخبر بذلك أصحابه، فلمّا خرج إلى الحديبيّة حسبوا أنّهم يدخلون مكّة في عامهم هذا، فلمّا
صدّوا عن دخولها قال المنافقون : ما حلقنا ولا قصّرنا ولا دخلنا المسجد الحرام. وكان غرضهم من ذلك أنّ رؤيا الرسول كانت كاذبة، فردّ الله عليهم بأنّ رؤياه صادقة البتّة، وما رآه كائن لا محالة في العام القابل.
وقوله :( بِالْحَقِ ) وصف لمصدر محذوف، أي : صدقا متلبسا بالحقّ، مطابقا للواقع.
ويحتمل كون «الباء» للقسم، فهو متّصل بقوله : «لتدخلنّ»، فهو جواب القسم المذكور، وعلى الأوّل جواب للمحذوف، والاعتراض بكلمة الاستثناء لطريان الموت، أو المرض على بعض المخاطبين، أو لتعليم العباد، أو حكاية لقول الملك أو النبي صلّى الله عليه وآله.
ومن المحتمل أن يكون «إن» بمعنى «إذ» كما في قوله :( إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى ) (١) وقوله : «إن أذنا قتيبة حزّتا».
و «التحليق» هو إزالة شعر الرأس بالحلق.
و «التقصير» هو قصّ الظفر، ونحو ذلك، وهما من مناسك «منى» والمكلّف مخيّر بينهما، وإن كان الأوّل أفضل، ولكنّ الثاني متعيّن على المرأة. والتفصيل في الفقه. فالمراد : محلّقا بعضكم، ومقصّرا آخرون.
وقوله :( فَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلَمُوا ) إشارة إلى أنّ تأخير وقوع تعبير هذه الرؤيا كان لمصلحة لا تعلمونها وكان الله عالما بها، فالاعتراض على النبيّ صلّى الله عليه وآله من ضعف الإيمان.
__________________
(١) الأعلى : ٩.
والمراد بـ «الفتح القريب» هو فتح خيبر، أو صلح الحديبية ؛ إذ حصل للمسلمين بهذا الصلح شوكة عظيمة فدخلوا مكّة بها.
وسببها كان اختلاط الفريقين، وميل كثير إلى الإسلام بما سمعوا من المسلمين من الآيات وأحكام الدين.
( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً ) ونحوه في سورة التوبة إلّا أنّه بدّل فيها( وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً ) بقوله :( وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ) (١) والمراد بإظهاره صلّى الله عليه وآله أو إظهار دينه على الاحتمالين في مرجع الضمير المنصوب جعله غالبا على سائر الأديان ؛ بحيث لا يبقى أحد إلّا وهو مؤمن به، متديّن بدينه.
قال الصادق عليه السلام : والله ما نزل تأويلها بعد ولا ينزل تأويلها حتّى يخرج القائم، فإذا خرج القائم لم يبق كافر بالله العظيم، ولا مشرك بالإمام إلّا كره خروجه، حتّى لو كان كافر أو مشرك في بطن صخرة، لقالت : يا مؤمن، في بطني كافر فاكسرني واقتله(٢) . انتهى.
وفي رواية عن النبيّ صلّى الله عليه وآله : لا يبقى على وجه الأرض [بيت مدر ولا وبر](٣) إلّا أدخله الله الإسلام ؛ إمّا بعزّ عزيز أو بذلّ ذليل، إمّا يعزّهم فيجعلهم الله من أهله فيعزّوا به، وإمّا يذلّهم فيدينون له. انتهى.
وقوله :( وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً ) يجري مجرى قوله تعالى في سورة الرعد
__________________
(١) التوبة : ٣٣.
(٢) بحار الأنوار ٥٢ : ٣٢٤، كمال الدين وتمام النعمة ٢ : ٦٧٠.
(٣) «ب» : بيت شعر أو وبر.
( وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ ) (١) .
وشهادة الله لنبيّة بالرسالة هو إنزاله الآيات على قلبه، وإجراؤها على لسانه، وإجراء المعجزات على يده. وهذه الشهادة كافية لصدقه، ولا حاجة له إلى شهادة غير الله.
ويمكن أن يكون المراد بها : جعله مرآة لأسمائه وصفاته ؛ كما عرفته.
( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْواناً سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ ) نصّ على شهادته برسالته سواء جعلنا «رسول الله» خبرا عن «محمّد» أو عطف بيان، أو بدلا عنه، فيكون خبره «أشدّاء».
وعلى الأوّل فهو خبر «للّذين آمنوا» فالجملة تجري مجرى قوله تعالى :( أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ ) (٢) فإنّهم كانوا يحترزون عن ثياب المشركين حتّى لا تلصق بثيابهم، وعن أبدانهم حتّى لا تمسّ أبدانهم، ويقتلونهم في الحروب بأشدّ قتلة ؛ وإن كانوا آباءهم أو إخوانهم، ولكنّهم إذا رأوا مؤمنا صافحوه وعانقوه وأعانوه في جميع أموره تقرّبا إلى الله تعالى، وطلبا لمرضاته.
و «السيماء» من السوم ؛ كما يظهر من المجمع(٣) ، ولكنّ تفسيرها بالعلامة
__________________
(١) الرعد : ٤٣.
(٢) المائدة : ٥٤.
(٣) انظر : مجمع البحرين ٢ : ٤٥٨ (سوم)، الكشّاف ٤ : ٣٤٧.
يرشد إلى أنّه من «الوسم»، و «السمة» وهي العلامة الّتي تحدث في جباههم من كثرة السجود. كذا قيل(١) .
وأنت خبير بأنّ هذا التفسير لا ينافي ما ذكر، فإنّه يقال : سامه : إذا أعلمه. ومن هنا كان يقال لعليّ بن الحسين عليهما السلام : «ذو الثفنات» لأنّه قد ظهر في مواضع سجوده أشباه الثفنات(٢) .
وقيل : علامتهم يوم القيامة أن تكون مواضع سجودهم أشدّ بياضا(٣) .
وقيل : كالقمر ليلة البدر(٤) .
وقيل : هو التراب على الجباه، لأنّهم يسجدون عليه(٥) .
وقيل : هو الصفرة والنحول(٦) .
وفي الأخبار الواردة في علائم الشيعة ما يرشد إلى ذلك.
وقرئ بالمدّ أيضا ؛ كما في الحديث : «وسوّمني بسيماء الإيمان»(٧) .
وبالجملة : كما يعرف المجرمون بسيماهم وهو سواد الوجه وزرقة العين، يعرف المؤمنون ببياض الوجه وإشراقه.
( وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ) الظاهر إنّ «مثلهم» مبتدأ، و «كزرع» خبره ؛ يعني أنّ مثلهم في التوراة ما ذكر من أنّ سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أو هذا مع ما
__________________
(١) انظر : مجمع البحرين ٢ : ٤٥٨ (سوم)، الكشّاف ٤ : ٣٤٧.
(٢) انظر : مجمع البحرين ٢ : ٤٥٨ (سوم)، الكشّاف ٤ : ٣٤٧.
(٣) مجمع البيان، المجلّد ٥ : ١٩٢.
(٤) مجمع البيان، المجلّد ٥ : ١٩٢.
(٥) مجمع البيان، المجلّد ٥ : ١٩٢.
(٦) مجمع البيان، المجلّد ٥ : ١٩٢.
(٧) الأمان : ٤٩.
تقدّم عليه من الشدّة على الكفّار والمرحمة على المؤمنين، ومثلهم في الإنجيل كزرع إلى آخره.
ولكن في بعض التفاسير : إنّ «ومثلهم» عطف على «مثلهم» فتكون خبرا لذلك ؛ يعني أنّ ما ذكر من الأوصاف حالهم ومثلهم في التوراة والإنجيل، فقوله «كزرع» استئناف لتمثيل على حدة، أو تفسير لما أبهم في قوله ذلك ؛ بناء على كونه إشارة مبهمة. ولعلّه بعيد ؛ كما لا يخفى.
و «الشطاء» و «الشطأ» و «الشطاء» و «الشطا» و «الشطو» و «الشط» : الفرخ، وهو الزرع إذا تهيّأ للانشقاق بعد ما يطلع، ويطلق على السنبل أيضا.
وفي مجمع الطريحيّ : وقد يستعمل الفرخ في كلّ صغير من الحيوان والنبات. وفي الخبر : نهي عن بيع الفروخ بالكيل من الطعام. قيل : المراد بالفروخ : الفروخ من السنبل وهي ما استبان وانعقد حبّه، وأفرخ الحبّ : إذا تهيّأ للانشقاق(١) . انتهى.
وقوله :( فَآزَرَهُ ) كآجره من المؤازرة كالمؤاجرة بمعنى : المعاونة، أو من الإيزار كالإيجار بمعنى : الإعانة.
وقرئ فآزره على كونه مجرّدا، والجميع بمعنى : التقوية والإعانة ؛ أي فقوي الزرع، [أو الله شطأه وأفراخه](٢) فلحقت الأمّهات حتّى صارت مثلها.
قوله :( فَاسْتَغْلَظَ ) ؛ أي فصار هذا الزرع أو هذا الشطأ غليظا بعد أن كان دقيقا.
__________________
(١) مجمع البحرين ٣ : ٣٧٨ (فرخ).
(٢) كذا في النسختين.
قوله :( فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ ) ؛ أي فقام على أصوله، والسوق جمع الساق وهو قصب الشجر والزرع.
قوله :( يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ ) ؛ أي يروع ويحسن في نظره، لقوّته وغلظه وحسن منظره.
وهذا مثل ضربه الله للنبيّ وأصحابه، فالزرع هو محمّد صلّى الله عليه وآله والشطأ أصحابه المؤمنون الّذين حوله المربّون بتربيته، وقد كانوا في بدو الأمر في غاية الضعف والقلّة ومحلّ الأذى من الكفّار، فتقوّوا واشتدّوا تدريجا بتلاحق المؤمنين وتعاونهم وازديادهم يوما فيوما، فاستغلظوا واستقاموا على أمرهم، وزاد شوكتهم وقوّتهم في ترويج الدين، فكفّ عنهم أيدي الكفّار، فشابهوا الزرع حيث إنّه كان في أوّل طلوعه وبروزه دقيقا ضعيفا يزعجه أدنى ريح، ثمّ صار قويّا غليظا.
وروي أنّه مكتوب في الإنجيل : إنّه يخرج قوم ينبتون نبات الزرع يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا ممّا يؤيّد الوقف بين المثلين ؛ كما ذكرناه. فافهم.
قوله :( لِيَغِيظَ ) ؛ أي قوّيناهم ونصرناهم حتّى بلغ أمرهم هذا المبلغ لغيظ الكفّار واشتعال أكبادهم بنار الغضب، فيكون هذا لهم عذابا معجّلا في الدنيا قبل عذاب الآخرة. ويمكن أن يكون تعليلا للتمثيل المذكور ؛ أي شبّهناهم بالزرع لإغاظة الكفّار.
وقيل : إنّه تعليل مقدّم لقوله :( وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا ) إلى آخره فإنّ الكفّار يغيظون بسماع هذا الوعد.
والمراد بالّذين آمنوا هم الّذين ثبتوا على الإيمان، وأقاموا على الطاعة في عهد النبيّ صلّى الله عليه وآله وفيما بعد وفاته إلى أن ماتوا. ولذا قال «منهم».
و «من» للتبعيض، فإنّ من هؤلاء الصحابة من لم يف بعهد الرسول بل خالفه، وردّ عليه في قوله صلّى الله عليه وآله : من كنت مولاه فعليّ مولاه(١) . فهذا الوعد لا يشمل جميعهم. كيف وقد ورد أنّ الناس ارتدّوا بعد وفاة رسول الله صلّى الله عليه وآله إلّا ثلاثة أو أربعة(٢) .
وفي بعض التفاسير : إنّ «منهم» للبيان وهو كما ترى تعصّب ضعيف البنيان.
والحاصل : أنّ هذا الوعد مخصوص بمن صدّق بجميع ما جاء به الرسول صلّى الله عليه وآله لسانا وقلبا ؛ مع امتثاله جميع أوامره ونواهيه، ثابتا على ذلك إلى آخر عمره، وأمّا غيره ففيه عرق من الكفر.
توضيح ذلك على ما يستفاد من بعض أكابر المحدّثين في رسالته الّتي ألّفها في تحقيق معنى الإيمان والكفر : أنّ الناس على صنفين :
الأوّل : من لم تصل إليه الدعوة النبويّة ولو في بعض الأمور لعدم سماعه أو لعدم فهمه، وهذا وإن كان كافرا كفر جهالة، إلّا أنّه من المستضعفين الّذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا(٣) ، فإن كان مقصّرا عوقب على
__________________
(١) الكافي ١ : ٢٨٧.
(٢) إشارة إلى أحاديث منها ما في البحار ٦٧ : ١٦٤.
(٣) إشارة إلى الآية ٩٨ من سورة النساء.
تقصيره، وإن كان قاصرا فلا عقاب عليه، لمنافاته للعدل.
والثاني : من وصلت إليه الدعوة النبويّة، وهذا على أقسام.
إذ منهم : من لم يصدّق بجميع ما وصل إليه أو بعضه لا بلسانه ولا بقلبه، فهذا كافر بحسبه كفر جحود، معذّب بعذاب أليم وعقاب عظيم ؛ كما يدلّ عليه آيات وأخبار كثيرة.
ومنهم : من يصدّق بالجميع بلسانه، وينكره بقلبه، فهذا كافر كفر نفاق، وعذابه أشدّ من سائر الكفّار ؛ كما قال :( إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ) (١) ولكنّه معصوم في دمه وماله، ويعامل معه معاملة المسلمين في جميع أموره.
ومنهم : من يصدّق بالجميع بقلبه، لظهور حقيقته عنده، ولكنّه ينكره بلسانه حسدا، أو استكبارا، أو بغيا وحقدا، أو تعصّبا، أو لغير ذلك من الأغراض الباطلة. فهذا كافر بحسبه كفر تهوّد ؛ كما قال :( الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) (٢) .
بل يمكن أن يقال : إنّ هذا هو الكفر الحقيقيّ، فإنّه عبارة عن الستر، ومنه الكافر للزارع، فإنّه يستر البذر في الأرض، والكافر المذكور يكتم ما عرفه من الحقّ، فيمكن أن يصرف أكثر الآيات الدالّة على تعذيب الكفّار إلى مثله لا إلى من اشتبه الأمر عليه ولم يحصّل بعد المجاهدة الحقّ ؛ كما هو هذا.
__________________
(١) النساء : ١٤٥.
(٢) البقرة : ١٤٦.
ولكنّ الله يقول :( وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا ) (١) فلا يفارق المجاهدة الحقيقيّة الوصول إلى الحقّ ؛ بمقتضى هذه الآية.
ومنهم : من يصدّق بالجميع لسانا وقلبا، ولكنّه لا يكون على بصيرة في دينه، ولا على معرفة بإمام زمانه. وهذا كافر كفر ضلالة ؛ كما قال صلّى الله عليه وآله : من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة(٢) .
ومنهم : من وصلت إليه الدعوة فصدّقها بلسانه وقلبه على بصيرة ومعرفة بإمامه ونائبه الحقّ، إلّا أنّه لم يمتثل جميع الأوامر والنواهي معتقدا بقبح مخالفته. وهذا فاسق عاص، بل كافر كفر فسوق، لما عرفته من انتقاض روح الإيمان بالمعصية.
وقد ورد أنّه : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن(٣) .
وقال في ترك الحجّ :( وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ ) (٤) فإن تاب فهو كمن لا ذنب له، وإلّا عذّب إن لم تدركه الشفاعة في المحشر، ولكنّه لا يخلّد في النار ؛ خلافا للوعيديّة من قولهم بخلود أصحاب الكبائر.
ومنهم : من وصلت إليه الدعوة فصدّقها بلسانه وقلبه، وأسلم وجهه لله في جميع أموره، واتّبع إمام زمانه في جميع أوامره ونواهيه ؛ وإن أتى بذنب استغفر الله منه من قريب. وهذا هو المؤمن الكامل وهو [من كان] من
__________________
(١) العنكبوت : ٦٩.
(٢) بحار الأنوار : ٣٢ : ٣٣١، كفاية الأثر : ٢٩٦، كمال الدين ٢ : ٤٠٩، المناقب ٣ : ٢١٧، كشف الغمّة ٢ : ٢٥٨، اليقين : ١٢٤، الإقبال : ٤٦٠.
(٣) الكافي ٢ : ٢٨٤.
(٤) آل عمران : ٩٧.
أصحاب أمير المؤمنين حقّا ؛ الّذين يجري فيهم قوله تعالى :( وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ) (١) .
فالحمد لله أوّلا وآخرا.
[قد وقع الفراغ من تسويد هذا الكتاب المستطاب، بعون الملك الوهّاب، في ليلة الاثنين التاسع والعشرون من شهر العاشر من سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة بعد الألف. وتمّ على يد العبد الضعيف، المسكين المستكين، الخائف المستجير عليّ بن الحسين القاسانيّ ابن عليّ بن أحمد النراقيّ ؛ المعروف في الآفاق، رفع الله درجتهما بحقّ محمّد وآله الطاهرين.
سيبقى خطوطي وكنت ترابا |
أيا ناظرا فيه قل لي دعاءا |
|
سالها درد رنج بايد ديد |
از رياضت شكنج بايد ديد |
|
تن به دود چراغ بايد ديد |
ترك خواب وفراغ بايد ديد](٢) |
__________________
(١) الفتح : ٢٩.
(٢) جاء هذا في آخر نسخة «أ».
اللمعة في تفسير
سورة الجمعة
بسم الله الرّحمن الرّحيم
[المقدّمة]
الحمد لله الملك الوهّاب الّذي بعث في الأميّين رسولا يتلو عليهم آياته ويعلّمهم الكتاب، والصلاة عليه وعلى آله المخصوصين بمعرفة حقائق القرآن، وفصل الخطاب.
أمّا بعد، فيقول السالك إلى الله، ابن علي مدد «حبيب الله» : إنّ هذه عجالة موسومة «باللمعة في تفسير سورة الجمعة»، كتبتها وأنا متبلبل البال، مختّل الحال ؛ في عصر عظم فيه البلاء، وكثر فيه الجور والجفاء، وغلب فيه الشقاء والشقاق على أهل القرى والأمصار، فلا يسعني إلّا الإيجاز والاختصار، فمن الله التوفيق والانتصار.
فأقول : قال الله سبحانه بعد البسملة الّتي فسّرناها في بعض ما أسلفناه من الأسفار :( يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ ) كما في «التغابن» ولكنّه سبحانه عبّر في «الحديد» و «الصفّ» و «الحشر» بالماضي، وفي «الإسراء» بالمصدر، وفي «الأعلى» بالأمر، والمؤدّى هو تنزّه الحقّ سبحانه وتنزيهه في الجميع وإن كان واحدا، كما قيل :
عباراتنا شتّى وحسنك واحد |
وكلّ إلى ذاك الجمال يشير |
ولكنّ التفنّن في التعبير باب من أبواب البلاغة، مفتوح للتنشّط عن السآمة، فإنّ التكرار والمواظبة على نهج واحد في المقال موجب للإسهاب والإملال، أو الإشارة إلى أنّ سبّوحيّته تعالى سرمديّة أزليّة أبديّة لا تختصّ بحال دون حال، وعالم دون عالم، وزمان دون زمان، بل كان سبّوحا في عالم اللاهوت قبل أن يخلق عالم الكائنات، وهو فعله المسبوق بالمادّة والمدّة كالعناصر والعنصريّات وعالم المبتدعات، وهو إمّا لم يسبق بشيء منهما كالعقول والنفوس المجرّدة وعالم المخترعات، وهو ما سبق بالأولى خاصّة كالفلك والفلكيّات، فلا تقيّد بالزمان والزمانيّات.
كيف وهو جلّ جلاله مسبّح لذاته بذاته قبل جميع المسبّحات والتسبيحات، وسبّوح وإن لم يسبّحه ولن يسبّحه أحد من الممكنات، ولذا كان التعبير بما في «الإسراء» أحرى وأولى، بل الفعل في هذه المقامات منسلخ عن الاقتران بالزمان كما لا يخفى على أولي النهى.
وفي «أنوار التنزيل» للبيضاويّ : إنّ مجيء المصدر مطلقا في «بني إسرائيل» أبلغ من حيث إنّه يشعر بإطلاقه على استحقاقه التسبيح من كلّ شيء، وفي كلّ حال(١) . انتهى.
والتسبيح من «سبح الرجل» إذا ذهب وبعد، ومنه السابح في الماء، ويقال : سبّحته بالتشديد إذا بعّدته عن الشين وبمعناه قدّسته من «قدس في الأرض» إذا ذهب فيها وبعد.
والفرق بين التسبيح والتقديس، مع أنّهما يرجعان إلى معنى واحد وهو
__________________
(١) أنوار التنزيل وأسرار التأويل ٢ : ٤٩٢.
تبعيد الله عن الشين والسوء، على ما قيل : إنّ الأوّل تنزيه الحقّ عن الشرك والعجز والنقص، والثاني تنزيهه عن شوائب الجسم ولوازم الإمكان فتدّبر.
وقد يقال : إنّ التقديس أعمّ ؛ إذ كلّ مقدّس مسبّح من غير عكس، وذلك لأنّ الإبعاد من الذهاب في الأرض أكثر من الإبعاد في الماء، فتأمّل.
والمعروف في معنى التقديس هو التطهير، من القدس بالضمّ، وبضمّتين(١) أي الطهر، ومنه الأرض المقدّسة وبيت المقدس كمجلس ومعظم، ويقال : تقدّس إذا تطهّر، وفسّر القدّوس بضمّ القاف وفتحها بالطاهر والمبارك، وعلى هذا فيتخالف مفادهما فتأمّل.
وقد يقال : إنّهما كالجار والمجرور إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا.
وكيف كان، المتبادر من التسبيح في هذه الآية وأشباهها هو تنزيه الحقّ بلسان القال ؛ كما يعتقده أرباب الشهود والمكاشفة بالنسبة إلى جميع الأشياء.
ويؤيّده جملة من الآيات القرآنيّة مثل قوله :( وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ) (٢) على قراءة الخطّاب.
وقوله :( كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ) (٣) .
وقوله :( إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ ) (٤) وغير ذلك.
وجملة من الأخبار الواردة في معجزات النبيّ صلّى الله عليه وآله والأئمّة المعصومين من إنطاق الجمادات والنباتات والعجم من الحيوانات.
__________________
(١) أي : قدس.
(٢) الإسراء : ٤٤.
(٣) النور : ٤١.
(٤) الأنعام : ٣٨.
وإن أبيت عن ذلك فاحمله على القدر المشترك بين التنزيه الفطريّ واللسانيّ، وهو مطلق الدلالة على تنزّه الحقّ عمّا لا يليق به من الشرك والنقائص، فلا يلزم استعمال اللفظة الواحدة في أكثر من معنى واحد، ولك أن تحمله على خصوص الأوّل ؛ إذ ما من شيء إلّا وهو مظهر بكينونته صفة من صفات جماله وجلاله ومظهر لها.
وفي كلّ شيء له آية |
تدل على أنّه واحد |
وفي الدعاء «اللهمّ إنّه ليس في السماوات دورات، ولا في الأرض غبرات، ولا في البحار قطرات، ولا في الجبال مدرات، ولا في الأشجار ورقات، ولا في الأجسام حركات، ولا في العيون لحظات، ولا في النفوس خطرات ؛ إلّا وهنّ بديموميّتك وبربوبيّتك عارفات، ولك شاهدات، وعليك دالّات، وفي ملك متحيّرات، وفي تحت جبروتك مذلّات».
وفي تفسير «حقائق القرآن» بعد ذكر الآية نظير : قدّس الله كلّ ذوات الأرواح والأشباح والأجسام بلسان العقول، ووجدان نور الإيجاد، ومباشرة أفعاله، لأنّه خصّ ذوي العقول برؤية نور الصفات في الأفعال، وهيّجهم ذلك إلى تقديسه وتنزيهه من علل الحدثان، وذلك تعريف الله نفسه إيّاهم بظهور الصفة في الفعل فعرفوه ثمّ قدّسوه، وخصّ ما دونهم من ذوي الحياة بمباشرة نور العقل، فوهبها منها أرواحا مسبّحة، وكذلك الجمادات لها لسان الفعل ؛ تصف بها الحقّ وتنزّهه، وذلك سرّ عجيب لا يعرفه إلّا من تفقّه قول الله :( وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ) ومن عظم قدر الله ذلك السرّ واللسان والوصف والتقديس شدّد الأمر في إدراكه بقوله :( وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ) .
وعن محيي الدين أنّه قال : إنّ المسمّى بالجماد والنبات له أرواح بطنت عن إدراك غير أهل الكشف إيّاه في العادة فلا يحسّ به مثل ما يحسّ به من الحيوان، فالكلّ عند أهل الكشف حيوان بل ناطق، غير أنّ هذا المزاج الخاصّ يسمّى إنسانا لا غير، زدنا مع الإيمان بالأخبار، الكشف ؛ فقد سمعنا الأحجار تذكر الله رؤية عيان بلسان تسمعه آذاننا، وتخاطبنا مخاطبة العارفين بجلال الله ممّا ليس يدركه كلّ إنسان.
وفي «مجمع البيان» : أي ينزّهه سبحانه كلّ شيء ويشهد له بالوحدانيّة والربوبيّة بما ركّب فيها من بدائع الحكمة وعجائب الصنعة الدالّة على أنّه قادر عالم حيّ قديم سميع بصير حكيم، لا يشبه شيئا، ولا يشبهه شيء(١) .
وكلمة «ما» إن قلنا بوضعها لما يطلق على ذوي العقول وغيرهم فدلالة الآية على تسبيح جميع الأشياء بالمنطوق واضحة، وإن قلنا باختصاصها بالثاني فالدلالة بالفحوى على الأوّل لأحقّيّته وأولويّته بذلك فتأمّل.
لا يقال : إنّ الآية دلّت على تسبيح ما في السماوات وما في الأرض، ولم تدلّ على تسبيح نفسهما، فإنّ الأرض أيضا من جملة ما في السماوات، حيث إنّها محيطة بها، ولعلّ المراد بـ «السماوات» جهات العلوّ لا خصوص الأفلاك.
وقد يقال : إنّ «اللام» في «لله» بمعنى «لأجل» والمفعول محذوف، أي، يسبّحه ما فيهما لأجل استحقاقه للتسبيح خالصا مخلصا له التسبيح وهو بعيد، ولعلّ تكلّفه لتعدّي «يسبّح» بنفسه، فلا حاجة إلى توسيط «اللام».
__________________
(١) مجمع البيان، المجلّد ٥ : ٤٢٨.
وفيه : إنّ من الأفعال ما يتعدّى تارة بالنفس، وأخرى بالحرف، كنصحته ونصحت له، وشكرته وشكرت له، وغفرته وغفرت له، وسجدته وسجدت له، ووهبته ووهبت له، ومنها : سبّحته وسبّحت له، قال الله :( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ ) (١) وقال :( يُسَبِّحُونَهُ ) (٢) وقال :( سَبِّحُوهُ ) (٣) وقال :( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ) (٤) فلا حاجة إلى هذا التكلّف.
وقد يقال : إنّ هذه «اللام» زائدة للتوكيد ؛ إذ من أقسامها كما في «المغني» المعترضة بين الفعل المتعدّي ومفعوله كما في قوله :
وملكت ما بين العراق ويثرب |
ملكا أجار لمسلم ومعاهد |
وقوله تعالى :( رَدِفَ لَكُمْ ) (٥) إن لم نقل فيه بالتضمّن لمعنى «اقترب لكم». فتأمّل.
وقد يقال : إنّها زائدة للتقوية، وفيه نظر، فإنّها تزاد فيما ضعف عن العمل كما في اسمي الفاعل والمفعول والمصدر، وفيما لو تأخّر الفعل عن معموله، وليس المقام من ذلك.
وكيف كان ففي الآية وأشباهها رمز لطيف إلى عتاب من يستنكف عن عبادة الله وتسبيحه بأنّ من يسبّحه جميع الموجودات من العلويّات والسفليّات كيف لا يتوجّه إلى تسبيحه المشركون الملحدون؟! وكأنّ قوله
__________________
(١) الجمعة : ١.
(٢) الأعراف : ٢٠٦.
(٣) الأحزاب : ٤٢.
(٤) النور : ٤١.
(٥) النمل : ٧٢.
تعالى :( الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ) (١) وإن كان ظاهره الوصف والنعت التعليل للمقالة السابقة والبرهان عليها، ضرورة أنّ المتّصف بهذه الصفات العليا المتّسم بهذه الأسماء الحسنى، مستحق بذاته للتسبيح والتقديس، بل التعبير بلفظة الجلالة كاف لصدق هذه المقالة، فإنّها اسم للذات المستجمعة لجميع الصفات الكماليّة : من الجماليّة والجلاليّة المقدّسة عن تمام النقائص الإمكانيّة، وقد فصّلنا ذلك مع سائر ما يتعلّق بهذه اللفظة في تفسير سورة «الفاتحة».
قال بعض العارفين : وأمّا كلمة «الله» فإنّه اسم الجمع لا ينكشف إلّا لأهل الجمع، وكلّ اسم يتعلّق بصفة من صفاته إلّا «الله» فإنّه يتعلّق بذاته وجميع صفاته، ولأجل ذلك هو اسم الجمع، أخبر الحقّ عن نفسه باسمه «الله»، فما يعرفه إلّا هو ولا يتكلّم به إلّا هو، لأنّ «الألف» إشارة إلى الأنانيّة والوحدانيّة، ولا سبيل للخلق إلى معرفتها إلّا الحقّ تعالى شأنه، وفي اسمه «الله» «لامان» الاولى إشارة إلى الجمال، والثانية إشارة إلى الجلال، والصفتان لا يعرفهما إلّا صاحب الصفات و «الهاء» إشارة إلى هويّته، وهويّته لا يعرفها إلّا هو، و [الخلق](٢) معزولون عن حقائقه، محتجبون بحروفه عن معرفته، وب «الألف» تجلّى الحقّ من أنانيّته لقلوب الموحّدين(٣) وب «اللام» الاولى تجلّى الحقّ من أزليّته لأرواح العارفين فانفردوا بانفراده، وب «اللام» الثانية تجلّى الحقّ
__________________
(١) الجمعة : ١.
(٢) في الأصل : الحقّ.
(٣) في الأصل كلمة غير مقروءة.
من جمال مشاهدته لأسرار المحبّين فغاروا في بحار حبّه، وب «الهاء» تجلّى الحقّ من هويّته لفؤاد المقرّبين فتاهوا في بيداء التحيّر من سطوات عظمته. انتهى.
ثمّ ليعلم أنّ هذه الأسماء المباركات ما عدا الثانية من أسماء الصفات الثبوتيّة الحقيقيّة الّتي هي عين ذاته، وأمّا هي وإن كانت كذلك في بادئ النظر إلّا أنّها في دقيق النظر كالسبّوحيّة، من الصفات السلبيّة بالمعنى الأعمّ، فإنّها على ما صرّح بعض الفحول أعمّ ممّا ينتطق فيها بحرف السلب، مثل قولهم : إنّه تعالى ليس بجسم، أو ليس بجوهر، أو ليس بعرض، أو لم ينتطق به، بل عبّر فيها بما يرجع إلى السلب من اللفظ البسيط كالقدّوس والسبّوح، فإنّ معناها كما عرفت أنّه تعالى منزّه ومبعّد عن النقائص، فهما بمنزلة قولهم : إنّه تعالى ليس بجسم، وليس له شريك، إلى غير ذلك. وهذا نظير أن تقول : زيد أمّيّ، فإنّه راجع إلى قولك : زيد ليس بكاتب، فتأمّل.
وليعلم أنّ صفاته تعالى إمّا سلبيّة، وإمّا ثبوتيّة، وتسمّى الأولى بـ «الجلاليّة» و «القهريّة» و «التنزيهيّة» ومرجعها إلى سلب النقائص كلّها عنه تعالى، وهذه ليست بعين الذات قطعا، فإنّ السلب عدم فلا يتطرّق فيما هو كلّ الوجود، والثانية بـ «الجماليّة» و «اللطفيّة» و «الإكراميّة» وهذه على أقسام ثلاثة :
أحدها : الحقيقيّة المحضة المجرّدة عن الإضافة إلى غيره تعالى كحياته تعالى وعلمه بذاته، وهذه عين ذاته مصداقا وإن اختلفت مفهوما واعتبارا، وهذا الاختلاف لا يوجب التعدّد في الذات ضرورة جواز انتزاع مفاهيم
مختلفة من مصداق واحد، والدليل على الاتّحاد أنّه لولاه لزم خلوّه تعالى في مقام الذات عن جميع الكمالات، وقد عرفت أنّه تعالى مستجمع في مرتبة ذاته لجميعها، فالقول بالزيادة كما عن الأشاعرة شطط من الكلام.
وثانيها : الإضافيّة المحضة كقادريّته وعالميّته وخالقيّته ونحوها من النسب الاعتباريّة، وهذه ليست بعين الذات وإلّا لزم كون الذات نسبة اعتباريّة لا وجود لها في الخارج، تعالى [الله] عن ذلك علوّا كبيرا.
وثالثها : الحقيقيّه ذات الإضافة كعلمه بما سواه من الأشياء وقدرته على جميع الممكنات، وهذه أيضا عين ذاته، ولا تضرّ الإضافة فإنّها إشراقيّة، قيل : أي إشراق الحقّ ومرتبة ظهوره، فتفطّن.
وكيف كان فلنرجع إلى تفسير هذه الأسماء، أمّا «القدّوس» فقد عرفت معناه، وأمّا «الملك» بفتح الميم وكسر اللام فهو القادر على تصريف الأشياء من الملك بالضمّ وهو السلطنة، ومنه قوله تعالى :( وَآتَيْناهُمْ ) «أي آل إبراهيم»( مُلْكاً عَظِيماً ) (١) وقوله :( قُلِ أللّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ ) (٢) وبمعناه «المليك» في قوله :( عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ) (٣) وهو أمدح من «المالك» بوجوه شتّى، ولذا رجّح كثير قراءته في سورة «الفاتحة» على قراءة «مالك» وصرّح الكفعميّ رحمه الله في «الرسالة الواضحة في تفسير سورة الفاتحة» بأنّ الملك من صفات الذات، بخلاف المالك فإنّه من صفات الأفعال، فتأمّل.
__________________
(١) النساء : ٥٤.
(٢) آل عمران : ٢٦.
(٣) القمر : ٥٥.
وأمّا «العزيز» فقيل : إنّه الّذي لا يعادله شيء.
وقيل : إنّه الغالب الّذي لا يغلب ؛ من العزّ وهو الغلبة، ومنه قوله تعالى :( وَعَزَّنِي فِي الْخِطابِ ) (١) .
وقيل معناه : القويّ من العزّة بمعنى القوّة.
وقيل : إنّه الّذي لا يكاد يوجد مثله، من العزّة بمعنى ندرة الوجود.
وقد يقال : إنّه باعتبار مظاهره الأكملين النادريّ الوجود.
وقيل : إنّه بمعنى السلطان المقتدر.
وأمّا «الحكيم» فقيل : إنّه القاضي.
وقيل : إنّه الّذي يحكم الأشياء ويتقنها، فالفعيل بمعنى المفعل.
وقيل : إنّه العالم بحقائق الأشياء، فمعناه : ذو الحكمة، وهي معرفة الحقائق، وفي الدعاء «يا من هو في صنعه حكيم»(٢) .
قال بعض الأفاضل رحمه الله : لأنّه خلق الأفلاك والعناصر بما فيها من الأعراض والجواهر، وأنواع المعادن والنبات، وأصناف الحيوانات على اتّساق وانتظام وإتقان وإحكام تحير فيه العقول والأفهام، ولا تفي بتفاصيلها الدفاتر والأقلام ؛ على ما يشهد به علم الهيئة والتشريح، وعلم الآثار العلويّة والسفليّة، وعلم الحيوان والنبات مع أنّ الإنسان لم يؤت من العلم إلّا قليلا، ولم يجد إلى الكثير سبيلا. انتهى.
ولهذه الأسماء المباركات خواصّ وآثار غريبة أشرنا إلى بعضها في
__________________
(١) ص : ٢٣.
(٢) مصباح الكفعميّ : ٢٤٩، البلد الأمين : ٤٠٣.
كتابنا المسمّى بـ «خواصّ الأسماء الحسنى» من أراد الاطّلاع عليه فليرجع إليه.
ولك في قراءته أواخر هذه الأسماء في هذه السورة «الجرّ» لكونها نعوتا للجلالة، و «النصب» رعاية للمحلّ أو قطعا للوصفيّة للمدح، «الرفع» للقطع وحذف المبتدأ، وقد حكي القراءة به أيضا عن بعض القرّاء.
ولمّا أشار سبحانه إلى الأصل الأوّل من أصول الدين وهو «إثبات الصانع» وما يليق به من توحيده، ووصفه بما يليق به وتنزيهه عمّا لا يليق به، أشار بقوله تعالى :( هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ ) إلى الأصل الثاني منها وهو «النبوّة»، فهذه الجملة وإن كانت منقطعة عن سابقها بحسب الظاهر، ولكنّها مرتبطة به بحسب المعنى، وإنّما صدّرها بالضمير لئلّا يتوّهم أنّ الموصول وصلته من التوابع المتعاقبة، الغير المقصودة بالأصل، بل يكون إشارة إلى أنّ النبوّة أيضا أصل مستقلّ يعتنى به عناية خاصّة ؛ كما يعتنى بالتوحيد.
وفي ذلك أيضا توقير خاصّ للرسول صلّى الله عليه وآله بكونه من جانب من يسبّح له جميع الأشياء من الملك والملكوت، ويكون له هذه الصفات العظمى والأسماء الحسنى، لا من جانب من لا يعتنى بشأنه من سكّان الثرى.
ولهذه الآية نظائر كثيرة في القرآن مثل قوله تعالى :( هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ) (١) وقوله :( هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ
__________________
(١) الحديد : ٤.
وَمَلائِكَتُهُ ) (١) وقوله :( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً ) (٢) وقوله :( وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ) (٣) وقوله :( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِ ) (٤) وقوله :( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ) (٥) إلى غير ذلك.
والآية مسوقة لبيان الامتنان على هذه الأمّة بالمنّة العظيمة، فإنّ في بعث الرسول حكما ومصالح ترجع إليهم في دنياهم وعقباهم ؛ إذ به يخرجون من الظلمات إلى النور، ومن المكاره إلى السرور، وفي ذلك أيضا تهيّج لهم على إطاعة الرسول في جميع ما يأمرهم به ويقول، وتجنيب لهم عن مخالفته في الفروع والأصول، ولهذا قال :( ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) (٦) .
وإنّما قال سبحانه :( فِي الْأُمِّيِّينَ ) ولم يقل «عليهم» أو «إليهم» لئلّا يتوهّم اختصاص رسالته بهم، مع أنّه كان مرسلا إلى الخلق كافّة.
«والأمّيّين» جمع الأمّيّ، ولا خلاف في أنّ ياءه للنسبة، وإنّما اختلفوا في المنسوب إليه، فقيل إنّه أمّة العرب، أي جماعتهم أو طريقتهم.
قيل : لأنّ أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة ولا يقدرون على قراءة
__________________
(١) الأحزاب : ٤٣.
(٢) الملك : ١٥.
(٣) الروم : ٢٧.
(٤) التوبة : ٣٣، الفتح : ٢٨.
(٥) الفتح : ٤.
(٦) الحشر : ٧.
المكتوب، والكتابة كانت فيهم عزيزة أو عديمة، فهم على أصل ولادة أمّهم.
وقيل : إنّه الأمّ، فمن لم يقدر على الكتب وعلى القراءة من الكتاب فهو أمّيّ، لأنّه على أصل ولادته حين تلده أمّه من الجهل بذلك.
وقيل : إنّه مكّة المعظّمة، فإنّها أمّ القرى، سمّيت بذلك لأنّ الأرض دحيت وبسطت من تحت الكعبة ؛ كما قال :( وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها ) (١) وكان ذلك في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة، فمن استوطن مكّة فهو أمّيّ، وقد فسّر أمّ القرى في قوله تعالى :( لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى وَمَنْ حَوْلَها ) (٢) بمكّة.
واختلف أيضا في إطلاق «الأمّي» على نبيّنا محمّد صلّى الله عليه وآله كما في قوله تعالى :( الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ) (٣) على الوجوه المذكورة، ولكن روى محمّد بن الحسن الصفّار في كتاب «بصائر الدرجات» في باب : «إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله كان يقرأ ويكتب بكلّ لسان» بإسناده إلى جعفر بن محمّد الصوفيّ قال : سألت أبا جعفر محمّد بن عليّ الرضا عليه السلام وقلت : يا ابن رسول الله، لم يسمّى النبيّ صلّى الله عليه وآله الأمّيّ؟ قال : ما يقول الناس؟ قلت : يزعمون إنّما سمّي الأمّيّ لأنّه
__________________
(١) النازعات : ٣٠.
(٢) الأنعام : ٩٢، الشورى : ٧.
(٣) الأعراف : ١٥٧.
لم يكتب. فقال : كذبوا عليه لعنهم الله، أنّى يكون ذلك والله يقول في محكم كتابه :( هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ ) (١) فكيف يعلّمهم ما لم يحسن؟ والله لقد كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يقرأ ويكتب باثنين وسبعين لسانا(٢) ، وإنّما سمّي الأمّيّ، لأنّه كان من أهل مكّة، ومكّة من أمّهات القرى، وذلك قول الله في كتابه :( لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى وَمَنْ حَوْلَها ) (٣)(٤) . انتهى.
وروى في هذا الكتاب أيضا عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله كان يقرأ ويكتب ويقرأ ما لم يكتب(٥) . وروى الصدوق أيضا الأوّل في «علل الشرائع» عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي عبد الله محمّد بن خالد البرقيّ، عن جعفر بن محمّد الصوفيّ قال : سألت(٦) إلى آخره.
وروى أيضا عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن عليّ بن حسّان وعليّ بن أسباط وغيره رفعه عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : إنّ الناس يزعمون أنّ رسول الله لم يكتب ولا يقرأ، فقال : كذبوا لعنهم الله، أنّى يكون ذلك وقد قال الله :( هُوَ الَّذِي ) إلى آخره، فيكون يعلّمهم الكتاب
__________________
(١) الجمعة : ٢.
(٢) وفي بعض النسخ : أو قال : ثلاث وسبعين.
(٣) الأنعام : ٩٢، الشورى : ٧.
(٤) بصائر الدرجات : ٢٢٥.
(٥) بصائر الدرجات : ٢٢٧.
(٦) علل الشرائع ١ : ١٢٤.
والحكمة وليس يحسن أن يقرأ ويكتب؟ قال : قلت : فلم سمّي الأمّيّ؟ قال : نسب إلى مكّة، وذلك قول الله( لِتُنْذِرَ ) إلى آخره. فامّ القرى مكّة، فقيل أمّيّ لذلك(١) .
ورواه أيضا عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار، عن سعد بن عبد الله(٢) إلى آخره.
وهذه الأخبار تؤيّد الوجه الأخير.
ويمكن حملها على أنّه صلّى الله عليه وآله كان قادرا على الكتابة والقراءة، ولكنّهما لم يصدرا عنه صلّى الله عليه وآله بحسب الظاهر لمصلحة، فإنّ جعل النبوّة في الأمّيّ الّذي لم يقرأ ولم يكتب أبعد من توهّم الاستعانة على ما أتى به من الحكمة بالحكم الّتي تلاها، والكتب الّتي قرأها، وأقرب إلى العلم بأنّ ما يخبرهم به من أخبار الأمم الماضية في السنين الخالية على وفق ما في كتبهم ليس إلّا بالوحي، كما صرّح به الطبرسيّ رحمه الله(٣) .
وصرّح أيضا بأنّ في جعل النبوّة في الأمّيّ موافقته لما تقدّمت البشارة به في كتب الأنبياء السالفة(٤) . ويوافقه ما في «الكشّاف» من أنّه جاء في حديث شعياء إنّي أبعث أعمى في عميان وأمّيّا في أمّيّين(٥) . فتأمّل.
ومن المحتمل أن يكون صلّى الله عليه وآله قبل بعثه أمّيّا لم يعرف
__________________
(١) بصائر الدرجات : ٢٢٦.
(٢) علل الشرائع ١ : ١٢٥.
(٣ و ٤) مجمع البيان، المجلّد ٥ : ٤٢٩.
(٥) الكشّاف ٤ : ٥٢٩.
الكتابة والقراءة كما قال :( ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَلَا الْإِيمانُ ) (١) ولكنّه عرّفهما بعده بالوحي وتعليم الله، فافهم ولا تغفل.
وفي «تفسير القمّيّ رحمه الله» قال : الأمّيّون الّذين ليس معهم كتاب. قال : فحدّثني أبي عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله :( هُوَ الَّذِي بَعَثَ ) إلى آخره قال : كانوا يكتبون ولكن لم يكن معهم كتاب من عند الله ولا بعث إليهم رسولا، فنسبهم الله إلى الأمّيّين(٢) . وهذا وجه رابع في الأمّيّين، فتأمّل.
والبعث يستعمل في معان كثيرة إلّا أنّ المراد منه في المقام الإرسال كما في قوله تعالى :( بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً ) (٣) ويمكن الفرق بينهما بأنّ في البعث نوعا من الزجر والشدّة على المبعوث عليه كما في قوله :( بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا أُولِي بَأْسٍ ) (٤) إلى آخره فليتأمّل.
والتنكير في «رسولا» محتمل للتعظيم والتفخيم كما في قول الشاعر :
له حاجب عن كلّ أمر يشينه
وجوه في الفرق بين الرسول والنبيّ :
وإنّما قال «رسولا» ولم يقل «نبيّا» لأنّه أمدح وأشرف، حيث إنّ كلّ
__________________
(١) الشورى : ٥٢.
(٢) تفسير القمّيّ ٢ : ٣٦٦.
(٣) النحل : ٣٦.
(٤) الإسراء : ٥.
رسول نبيّ ولا عكس، وقد ذكر جماعة أنّ الرسول : الّذي معه كتاب من الأنبياء، والنبيّ : الّذي ينبئ عن الله ؛ وإن لم يكن له كتاب.
قال نور الدين الجزائريّ : وأورد عليه أنّ «لوطا» و «إسماعيل» و «أيّوب» و «هارون» كانوا مرسلين كما ورد في التنزيل ولم يكونوا أصحاب كتب مستقلّة.
وقد يفرّق بينهما بأنّ الرسول : من بعثه الله بشريعة جديدة ناسخة، والنبيّ صلّى الله عليه وآله : من بعثه لتقرير شريعة سابقة، وفي بعض الأخبار : أنّه سئل عن عدد الأنبياء، فقال : أربعة وعشرون ألفا، فقيل : فكم الرسول منهم؟ فقال : ثلاثمائة وثلاثة عشر. فتدبّر.
وربّما يفرّق بينهما بأنّ الرسول من يأتيه الملك عيانا ومشافهة، والنبيّ : من يأتيه في منامه، ويدلّ عليه بعض الأخبار، فتأمّل.
وربّما يفرّق بينهما بأنّ الرسول من يجب عليه التبليغ إلى الخلق ؛ بخلاف النبيّ، فإنّه قد يكون نبيّا على نفسه خاصّة، ومن هنا قيل : إنّ للرسول يدين يد يأخذ بها عن الله، ويد يعطي بها الخلق ؛ بخلاف النبيّ، فإنّ يده آخذة. وهذا هو الفرق بين الرسالة والنبوّة، فتأمّل.
وقيل : إنّ النبيّ والرسول كالجار والمجرور ؛ إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا.
وقيل : إنّهما مترادفان، فتأمّل.
وكيف كان فلا شكّ في استعمال كلّ منهما في الآخر وأمد حيّة الرسول وأشرفيّته.
وكلمة «من» في «منهم» للتبعيض، وفيه دلالة على أنّه صلّى الله عليه وآله كان من الأمّيّين.
ومحلّ قوله «يتلو» في قوله :( يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ ) النصب لكونه صفة لـ «رسولا» بعد الصفة، أو لكونه حالا منه، والحال لا يأتي من النكرة إلّا إذا كانت مخصّصة بوصف كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى :( وَلَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ ) (١) ، إن لم نجعل «مصدّقا» حالا من الضمير المستقرّ في الجار والمجرور، وكذلك في المقام وكما في قول الشاعر :
نجّيت يا ربّ نوحا واستجبت له |
في فلك ما خر في اليمّ مشحونا |
أو بإضافة كما في قوله :( أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلِينَ ) (٢) أو مسبوقة بنفي أو نهي أو استفهام.
والتلاوة : القراءة، والفرق بينهما على ما حكي عن «الراغب»، أنّ التلاوة تختصّ باتّباع كتب الله المنزلة تارة بالقراءة، وتارة بالارتسام لما فيه من أمر ونهي وترغيب وترهيب، أو ما يتوهّم فيه ذلك، وهي أخصّ من القراءة، فكلّ تلاوة قراءة ولا عكس(٣) .
فقوله :( إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا ) (٤) فهذا بالقراءة، وقوله :( يَتْلُونَهُ حَقَ
__________________
(١) البقرة : ٨٩.
(٢) فصّلت : ١٠.
(٣) المفردات : ١٦٧.
(٤) الأنفال : ٣١، الأحقاف : ٧.
تِلاوَتِهِ ) (١) المراد به الاتّباع بالعلم والعمل، وإنّما استعمل التلاوة في قوله تعالى :( وَاتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ ) (٢) لمـــّـا كان بزعم الشياطين إنّما يتلونه من كتب الله.
وقد يقال : إنّ القراءة هي جمع الحروف، والتلاوة اتّباعها.
قال الطبرسيّ رحمه الله : أي يقرأ عليهم القرآن المشتمل على الحلال والحرام والحجج والأحكام(٣) إلى آخره. انتهى.
وفيه أيضا إشعار بأخصّيّة التلاوة، ويؤيّده العرف، فإنّه لا يقال لمن يقرأ كتب الحكايات والخرافات : إنّه يتلوها، فالمراد بالآيات، الكلمات الحقّة المنزّلة من السماء، ويمكن التعميم في الآيات بحيث تشمل التدوينيّة والتكوينيّة من الآفاقيّة والأنفسيّة، فتأمّل.
والمراد «بالتزكية» التطهّر من الكفر والشرك والذنوب والصفات الرذيلة والأخلاق الغير المحمودة الّتي وضعت لمعالجتها كتب الأخلاق، وقد قال صلّى الله عليه وآله : إنّي بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق(٤) .
قال النيسابوريّ : لأنّ الإرشاد يتمّ بأمرين بالتخلية والتحلية، فكما يجب على المعلّم التنبيه على نعوت الكمال ليحظى المتعلّم بها، يجب عليه التحذير عن سمات النقصان ليتحرّز عنها، وذلك بنحو ما يفعله النبيّ صلّى الله عليه وآله من التلاوة وتعليم الكتاب من الوعد والإيعاد والتذكير
__________________
(١) البقرة : ١٢١.
(٢) البقرة : ١٠٢.
(٣) مجمع البيان، المجلّد ٥ : ٤٢٩.
(٤) مكارم الأخلاق : ٨.
والتسبّب بأمور الدنيا ليقوّي بها دواعيهم إلى الإيمان والعمل الصالح إلى آخره.
وفي سورة «البقرة» :( وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَما أَرْسَلْنا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ) (١) وفيها أيضا حكاية عن دعاء إبراهيم عليه السلام :( رَبَّنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) (٢) وفي سورة «آل عمران» :( لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ ) (٣) .
ولعلّ وجه تقديم التزكية الّتي هي عبارة عن رياضة النفس، وتصفية القلب عن الكدورات الشيطانيّة، وتنقيته عن أوساخ التعلّقات الدنيويّة، وتخليته عن أرجاس الحرص والطمع والبخل والحقد والحسد ونحوها من الأمراض القلبيّة، على تعليم الكتاب والحكمة في هذه الآية وأشباهها للإشارة إلى أنّ تعلّمهما لا يفيد بدونها، كيف والقلوب أوعية للعلوم والمعارف، فلا بدّ في تأثّرها بها من إفراغها عمّا لا يناسبها، ولا سيّما عن أضدادها ومنافياتها من الشهوات النفسانيّة، واللذّات الجسمانيّة.
وقد روي أنّه ليس العلم في السماء حتّى ينزل عليكم، ولا في الأرض
__________________
(١) البقرة : ١٥٠ ـ ١٥١.
(٢) البقرة : ١٢٩.
(٣) آل عمران : ١٦٤.
فينبت لكم، بل هو مكنون فيكم فتخلّقوا بأخلاق الله يظهر لكم.
وفي رواية : من أخلص لله أربعين صباحا فتح الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه(١) .
وفي اخرى : ما أجمل عبد ذكر الله أربعين يوما إلّا وهداه الله في الدنيا، وبصّره داءها، وأثبت الحكمة في قلبه، وأنطق بها لسانه(٢) .
والحاصل : إنّ تزكية النفس مقدّمة لحصول العلم الحقيقيّ وقبول القلب لآثاره، والمراد بالعلم الحقيقيّ هو المعارف الحقّة، والأسرار الغيبيّة المكنونة الّتي لا يطّلع عليها إلّا الأوحديّ الّذي شرح الله صدره للإيمان، وهداه بنوره إلى الصراط المستقيم، وهذا العلم يسمّى بـ «علم المكاشفة»، وإليه أشار عليّ بن الحسين عليهما السلام فيما نسب إليه من شعره :
إنّي لأكتم من علمي جواهره |
كي لا يرى الحقّ ذو جهل فيفتتنا |
|
فقد تقدّم في هذا أبو حسن |
إلى الحسين ووصّى قبله الحسنا |
|
يا ربّ جوهر [قدس] لو أبوح به |
لقيل لي أنت ممّن يعبد الوثنا |
|
ولا ستحلّ رجال مسلمون دمي |
يرون أقبح ما يأتونه حسنا |
فإن قلت : إذا كان حصول العلم مرتّبا على التزكية فلم أخّرها في دعوة إبراهيم عليه السلام؟ قلت : أوّلا، إنّ «الواو» لا تدلّ على الترتيب، وإنّما ذكرنا ما ذكرناه من باب الاحتمال، ولعلّ وجه التقديم لمكان زيادة الاهتمام بالتزكية، كيف والغرض الأصليّ من تحصيل العلم هو العمل الّذي يحصل به
__________________
(١) جامع الأخبار : ٩٤.
(٢) الكافي ٢ : ١٦.
التزكية، والغايات متقدّمة في الذهن، متأخرّة في الخارج ؛ كما في السرير وجلوس السلطان عليه، ولذا قد تتقدّم الغاية في مقام الذكر واللفظ نظرا إلى تقدّمها في الوجود الذهنيّ، وقد تؤخّر نظرا إلى الوجود الخارجيّ.
وثانيا : إنّ العلم المسبوق بالتزكية هو علم المكاشفة دون علم المعاملة المسمّى بالعلم الرسميّ، فإنّ غير المتذكّى أيضا يحصّله بالكسب والتعلّم كسائر المكاسب، وربّما يحصل له بعد تعلّمه والعمل به حظّ التزكية بعون الله وتوفيقه فتدبّر.
والمراد بـ( الْكِتابَ ) ظاهر القرآن وقشره وب( الْحِكْمَةَ ) حقائقه وبواطنه الّتي لا يعلمها إلّا الله والراسخون في العلم.
ويحتمل أن يراد بـ «الكتاب» الكتابة وعلم الخطّ كما يرشد إليه بعض الروايات المتقدّمة في تفسير «الأمّي» و «بالحكمة» قراءة القرآن، وقد أطلق تعالى «الحكيم» عليه في مواضع من التنزيل كما في قوله :( يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ) (١) وغيره لاشتماله على الحكمة كما لا يخفى، أو على المحكمات من الآيات.
وقيل : المراد بـ «الكتاب» القرآن، وب «الحكمة» السنّة النبويّة بالمعنى الأعمّ.
وقيل : المراد بـ «الكتاب» الفرائض والواجبات، وب «الحكمة» السنن والآداب.
__________________
(١) يس : ١ ـ ٢.
وقيل : المراد بـ «الكتاب». وفي «مجمع البيان» «الكتاب» القرآن، و «الحكمة» الشرائع.
وقيل : إنّ الحكمة تعمّ الكتاب والسنّة وكلّ ما أراده الله، فإنّ الحكمة هي العلم الّذي يعمل عليه فيما يجتبى أو يجتنب من امور الدين والدنيا(١) . انتهى.
وقيل : المراد بـ «الكتاب» أحكام الرسالة والنبوّة من العقائد الدينيّة وعلم الأخلاق النفسيّة وعلم الأعمال البدنيّة، وب «الحكمة» كمال القوّة العمّالة، فتأمّل.
ويستفاد من «تفسير النيشابوريّ» أنّ المراد بـ «الآيات» لفظ الفرقان المتلوّ عليهم، وب «الكتاب» معانيه وحقائقه، قال : وذلك أنّ التلاوة وإن كانت مطلوبة لبقاء لفظها على ألسنة أهل التواتر فيبقى مصونا من التحريف، ولأنّ لفظه ونظمه معجز، وفي تلاوته نوع عبادة ؛ ولا سيّما في الصلوات، إلّا أنّ الحكمة العظمى والمقصود الأسنى تعليم ما فيه من الدلائل والأحكام. انتهى.
وب «الحكمة» الإصابة في القول والعمل جميعا، فلا يسمّى حكيما إلّا وقد اجتمع فيه الأمران، فيضع كلّ شيء موضعه، قال : ولهذا عبّر عنها ـ أي عن الحكمة ـ بعض الحكماء بأنّها التشبّه بالإله بقدر الطاقة البشريّة، ويناسبه قوله : «تخلّقوا بأخلاق الله»(٢) .
__________________
(١) مجمع البيان، المجلّد ٥ : ٤٢٩.
(٢) بحار الأنوار ٥٨ : ١٢٩.
وعن ابن وهب قلت لمالك : ما الحكمة؟ قال : معرفة الدين والفقه فيه والاتّباع له، وإليه ذهب الشافعيّ، وهي سنّة رسول الله صلّى الله عليه وآله لأنّه ذكر تلاوة القرآن ثمّ تعليمه، ثمّ عطف عليه الحكمة فيكون شيئا خارجا عنهما، وليس ذلك إلّا سنة الرسول، فإنّ الدلائل العقليّة الدالّة على التوحيد والنبوّة وما يتلوهما مستقلّة بالفهم، فحمل اللفظ على ما لا يستفاد إلّا من الشرع أولى.
وقيل : هي الفصل بين الحقّ والباطل من الحكم.
وقيل : المراد بـ «الكتاب» الآيات المحكمات، وب «الحكمة» المتشابهات.
وقيل : هي ما في أحكام الكتاب من الحكم والمصالح. انتهى كلامه.
وهو ملخّص ما ذكره الفخر الرازيّ في تفسيره، وفيه عند تفسير دعوة إبراهيم عليه السلام المذكورة في سورة «البقرة»، واعلم أنّه تعالى لمـــّـا طلب بعثة رسول منهم إليهم ذكر لذلك الرسول صفات أوّلها قوله :( يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ ) (١) وفيه وجهان :
الأوّل : أنّها الفرقان الّذي أنزل على محمّد صلّى الله عليه وآله لأنّ الّذي كان يتلوه عليهم ليس إلّا ذلك، فيجب حمله عليه.
الثاني : يجوز أن تكون «الآيات» هي الأعلام الدالّة على وجود الصانع وصفاته سبحانه وتعالى، ومعنى تلاوته إيّاها عليهم أنّه كان يذكّرهم بها ويدعوهم إليها ويحملهم على الإيمان بها.
__________________
(١) البقرة : ١٢٩.
وثانيها : قوله :( وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ ) والمراد أنّه يأمرهم بتلاوة الكتاب ويعلّمهم معاني الكتاب وحقائقه. إلى أن قال : والصفة الرابعة من صفات الرسول صلّى الله عليه وآله، قوله :( وَيُزَكِّيهِمْ ) واعلم أنّ كمال حال الإنسان في أمرين :
أحدهما أن يعرف الحقّ لذاته.
والثاني : أن يعرف الخير لأجل العمل به، فإن أخلّ بشيء من هذين الأمرين لم يكن طاهرا عن الرذائل والنقائص، ولم يكن زكيّا عنها(١) . انتهى.
وكلمة (إن) في قوله :( وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ ) إلخ ؛ ليست شرطيّة وصليّة كما ربّما يسبق إلى بعض الأذهان، بل هي مخفّفة من المثقّلة تهمل عن العمل لدخولها على الجملة الفعليّة، ويجوز حينئذ دخولها على المضارع الناسخ كما في قوله :( وَإِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ ) (٢) والأكثر في ذلك دخولها على الماضي الناسخ كما في هذه الآية، وفي قوله :( وَإِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً ) (٣) وقوله :( وَإِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ ) (٤) وقوله :( إِنْ كانَ وَعْدُ رَبِّنا لَمَفْعُولاً ) (٥) وقوله :( وَإِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ ) (٦) ، وقوله :( إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ ) (٧) .
__________________
(١) التفسير الكبير ٤ : ٦٦ ـ ٦٧.
(٢) القلم : ٥١.
(٣) البقرة : ١٤٣.
(٤) الإسراء : ٧٣.
(٥) الإسراء : ١٠٨.
(٦) الأعراف : ١٠٢.
(٧) الصافّات : ٥٦.
قال ابن هشام : وحيث وجدت «إن» وبعدها «اللام» المفتوحة كما في هذه الأمثلة فاحكم بأنّ أصلها التشديد.
وتسمّى هذه «اللام» بالفارقة، لأنّها مع إفادة زيادتها التأكيد للنسبة تفيد الفرق بين «إن» المخفّفة والنافية، وقد يقال إنّها لام الابتداء تدخله في خبر الناسخ، قيل : فإنّها كانت مختصّة بالدخول على المبتدأ والخبر في الأصل، فلمّا خفّفت وضعف شبهها بالفعل جاز دخولها على الفعل لئلّا تفارق محلّها بالكلّيّة.
قال في الكشّاف : و «إن» في( وَإِنْ كانُوا ) هي المخفّفة من الثقيلة و «اللام» دليل عليها، أي كانوا في ضلال لا ترى ضلالا أعظم منه(١) . انتهى.
وقد يقال : إنّ «إن» في الآية وأمثالها نافية، و «اللام» بعدها بمعنى إلّا، ولذا فسّر الطبرسيّ رحمه الله هذه الجملة بقوله : ومعناه وما كانوا من قبل بعثه إليهم إلّا في عدول عن الحقّ، وذهاب عن الدين بيّن ظاهر(٢) . انتهى.
وهذا إنّما يصحّ على مذهب الكوفيّين حيث زعموا أنّ «إنّ» لا تخفّف، وأنّه إذا قيل : «إن زيد لمنطلق» فـ «إن» فيه نافية و «اللام» بمعنى إلّا.
قال ابن هشام : ويردّه أنّ منهم من يعملها مع التخفيف، حكى سيبويه : إن عمرا لمنطلق.
وقرأ الحرميّان( وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ ) (٣) . انتهى.
__________________
(١) الكشّاف ٤ : ٥٣٠.
(٢) مجمع البيان، المجلّد ٥ : ٤٢٩.
(٣) هود : ١١١.
والمراد بـ (الضلال المبين) أي الظاهر هو الشرك باتّخاذهم الأصنام آلهة، والعمل بقوانين الجاهليّة من الاقتسام بالأزلام وأكل النطيحة والموقوذة والمتردية ونحو ذلك، والجملة في محلّ الحال، والرابطة «الواو» والضمير، أي يتلو آياته عليهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة ويزكّيهم، والحال أنّهم كانوا قبل ذلك ضالّين عن طريقة الحقّ لا يهتدون إليه سبيلا، فامتنّ الله عليهم بهذه المنّة العظيمة حيث كانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم منها ؛ كما صرّح بذلك في موضع آخر من كتابه.
و( آخَرِينَ ) في قوله تعالى :( وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لمـــّـا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) إمّا عطف على( الْأُمِّيِّينَ ) فيكون في محلّ الجرّ، أي بعثه في الأمّيّين الموجودين في عهده صلّى الله عليه وآله وفي الّذين سيوجدون بعدهم، وفيه ما لا يخفى، نعم لو عدّى «البعث» بـ «على» أو بـ «إلى» لاستقام المعنى في هذا العطف، وإمّا على الضمير المنصوب في( يُعَلِّمُهُمُ ) أي يعلّم الموجودين منهم بالدعوة الشفاهيّة وغير الموجودين بالدعوة العامّة الّتي تصل إليهم بالوسائط، كما قال :( لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ) (١) .
و «آخرين» بفتح «الخاء» جمع آخر كذلك، وإنّما جمع على «الواو» أو «الياء» و «النون» لأنّه وصف حيث إنّه في الأصل أفعل للتفضيل كأفضل، ومعناه على ما صرّح به الرضيّ رحمه الله أشدّ تأخّرا، قال في البحث عن غير المنصرف : وأمّا الأخر فإنّه جمع أخرى الّتي هي مؤنّث آخر، وهو أفعل التفضيل بشهادة الصرف ؛ نحو : آخر، آخران، آخرون وأواخر وأخرى
__________________
(١) الأنعام : ١٩.
أخريان أخريات، وآخر مثل الأفضل الأفضلان الأفضلون والأفاضل والفضليّ والفضليان والفضليات والفضل، فمعنى آخر في الأصل أشدّ تأخّرا، وكان في الأصل معنى جاء زيد ورجل آخر، رجل أشدّ تأخّرا من زيد في معنى من المعاني، ثمّ نقل إلى معنى غير، فمعنى رجل آخر رجل غير زيد.
ولا يستعمل إلّا فيما هو من جنس المذكور أوّلا، فلا يقال جاء زيد وحمار آخر ولا امرأة أخرى، إلى أن قال : ولمّا خرج آخر وسائر تصاريفه عن معنى التفضيل استعملت من دون لوازم أفضل التفضيل، أعني «من» و «الإضافة» و «اللام» إلى آخره. انتهى.
وذكر أبو البقاء في كلّيّاته : إنّ معنى آخر في الأصل أشدّ تأخّرا في الذكر، ثمّ أجري مجرى غيره.
وأمّا الآخر بكسر «الخاء» كالضارب فهو ضدّ الأوّل، ومنه قوله :( هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ ) (١) فمؤنّثه الآخرة كالضاربة، وقد نظم ذلك أبو البقاء بقوله :
مقابل الأوّل قل آخر |
كفاعل تأنيثه الآخره |
|
وآخر أفعل تأنيثه |
أخرى فهاك درّة فاخره |
والمراد بالآخرين في الآية : تابعي الصحابة وتابعي التابعين، إلى يوم القيامة ؛ على ما قيل.
وكلمة (لما) الداخلة على المضارع تجزمه وتنفيه وتقلبه ماضيا ككلمة «لم» ولكنّها تفارقها في أنّ منفيها مستمرّ النفي إلى الحال، وفي أنّ منفيها لا يكون إلّا قريبا من الحال، وأنّ منفيها متوقّع الثبوت كما في قوله :
__________________
(١) الحديد : ٣.
( بَلْ لمـــّـا يَذُوقُوا عَذابِ ) (١) وقوله :( وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ ) (٢) فاللّحوق المنفي في الآية متوقّع الثبوت، والظاهر أنّ المراد به اللحوق في الإيمان، وأنّ الضمير المجرور في( مِنْهُمْ ) راجع إلى( الْأُمِّيِّينَ ) فلا دلالة في الآية على لحوق غيرهم، فالأولى إرجاعه إلى الناس كافّة، لاشتراكهم معهم في الدعوة، ولزوم الإجابة.
ويؤيّده : ما روي من أنّه لمـــّـا نزلت هذه الآية قيل : من هم يا رسول الله؟ فوضع يده على كتف سلمان ثمّ قال : لو كان الإيمان عند الثريّا لتناوله رجال من هؤلاء(٣) .
وفي رواية : لنالته رجال من هؤلاء(٤) .
ومن هنا قيل : إنّ المراد «بالآخرين» الّذين يأتون بعدهم إلى يوم القيامة.
وعن الباقر عليه السلام : هم الأعاجم ومن لا يتكلّم بلغة العرب(٥) .
وقد يقال : إنّ المراد بهم الخصّيصون من امّته الّذين يأتون من بعده يؤمنون بالغيب، وهم الّذين كان الرسول صلّى الله عليه وآله يتشوّق إليهم، كما روي في بعض كتب العرفان مرسلا : إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله رأى يوما أبا ذرّ يمشي فقال : «مسكين أبو ذر يمشي وحده وهو في السماء فرد، وأبو ذر في الأرض فرد كمن فرد الفرد».
__________________
(١) ص : ٨.
(٢) الحجرات : ١٤.
(٣) تفسير الإمام العسكريّ عليه السلام : ١٢٠.
(٤) بحار الأنوار ١٦ : ٣١٠.
(٥) نفس المصدر.
ثمّ قال : يا أبا ذرّ، إنّ الله جميل يحبّ الجمال، يا أبا ذرّ، أتدري ما غمّي وفكري وإلى أيّ شيء اشتياقي؟ فقال أصحابه : خبّرنا يا رسول الله بغمّك وفكرك، قال : وا شوقاه إلى لقاء إخواني ؛ يكونون من بعدي، شأنهم شأن الأنبياء، وهم عند الله بمنزلة الشهداء، يفرّون من الآباء والامّهات، والإخوة والأخوات، ابتغاء مرضاة الله، وهم يتركون المال، ويذلّون أنفسهم بالتواضع، لا يرغبون في الشهوات وفضول الدنيا، يجتمعون في بيت من بيوت الله مغمومين محزونين من حبّ الله، قلوبهم إلى الله، وروحهم من الله، وعلمهم لله، إذا مرض واحد منهم هو أفضل من عبادة سنة.
وإن شئت أزيدك يا أبا ذرّ؟ قال : بلى يا رسول الله، [قال :] الواحد منهم يؤذيه قملة في ثيابه فله عند الله أجر سبعين حجّة وغزوة، وكان له أجر عتق أربعين رقبة من ولد إسماعيل، كلّ واحد منهم باثني عشر ألفا.
وإن شئت أزيدك يا أبا ذرّ؟ قال : بلى يا رسول الله، قال : الواحد منهم يذكر أهله ثمّ يغتمّ فيكتب له بكلّ نفس ألف ألف درجة.
وإن شئت أزيدك يا أبا ذرّ؟ قال : بلى يا رسول الله، قال : الواحد منهم يصلّي ركعتين في أصحابه أفضل عند الله من رجل يعبد الله تعالى في جبل لبنان مثل عمر نوح.
وإن شئت أزيدك يا أبا ذرّ؟ قال : بلى يا رسول الله، قال : الواحد منهم يسبّح الله تسبيحة خير له يوم القيامة من أن يصيّر معه جبال الدنيا ذهبا.
وإن شئت أزيدك يا أبا ذرّ؟ قال : نعم يا رسول الله، [قال :] نظرة ينظر إلى أحدهم أحبّ إلى الله من نظرة إلى بيت الله، ومن نظر إليه فكأنّما ينظر إلى
الله، ومن سرّه فكأنّما سرّ الله، ومن أطعمه فكأنّما أطعم الله.
وإن شئت أزيدك يا أبا ذر؟ قال : بلى يا رسول الله، قال : يجلس إليهم قوم مصرّون مثقلون من الذنوب ؛ ما يقومون من عندهم حتّى ينظر الله إليهم ويغفر لهم ذنوبهم.
يا أبا ذرّ ضحكهم عبادة، ومزاحهم تسبيح، ونومهم صدقة، ينظر الله إليهم في كلّ يوم سبعين مرّة.
يا أبا ذرّ، إنّي إليهم مشتاق. ثمّ أطرق صلّى الله عليه وآله رأسه مليّا، ثمّ رفع رأسه وبكى حتّى هملت عيناه فقال : وا شوقاه إلى لقائهم؟
ويقول صلّى الله عليه وآله : أللّهمّ احفظهم وانصرهم على من خالفهم، وأقرّ عيني بهم يوم القيامة، ثمّ قرأ :( أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ) (١) (٢) . انتهى.
وروى قريبا منه أحمد بن فهد الحلّيّ رحمه الله في كتابه المسمّى بـ «التحصين» إلّا أنّه قال : [قال] رسول الله : أتدرون ما غمّيّ، وفي أيّ شيء تفكّري، وفي أيّ شيء اشتياقي؟ قال أصحابه : لا يا رسول الله، ما علمنا هذه من أيّ شيء، أخبرنا بغمّك وتفكّرك وتشوّقك، قال النبيّ صلّى الله عليه وآله : أخبركم إن شاء الله.
ثمّ تنفّس الصعداء وقال : هاه شوقا إلى إخواني من بعدي، فقال أبو ذرّ : يا رسول الله، أو لسنا إخوانك؟ قال : لا، أنتم أصحابي، وإخواني يجيئون من
__________________
(١) يونس : ٦٢.
(٢) التحصين، لابن فهد : ٢٥.
بعدي، شأنهم شأن الأنبياء، قوم يفرّون إلى آخره.
وقد ذكرناه بجملته في كتابنا المسمّى بـ «مفتاح السعادات».
وقوله :( وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) إشارة إلى أنّ الّذي يمكّن رجلا أمّيّا يتيما لا مال له ولا عشيرة قويّة تنصره من هذا الأمر العظيم «أي الرسالة» حتّى ينقاد له في زمان يسير من الناس كثير مع عتوّهم وقوّتهم، لا يكون إلّا عزيزا لا يغلب، حكيما لا يناقش في تدبيره وحكمته، فهذا الرجل مؤيّد من عند الله، ومجتباه من جميع خلقه، وقد شهدت العقول الفطريّة السليمة بصدقه في رسالته، وقد أراد المشركون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متمّ نوره ولو كره المشركون.
والمشار إليه «بذلك» في قوله( ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ) هو بعث الله النبيّ الأمّيّ بالنبوّة على الوجه المذكور، فضله وإحسانه يختصّ به من يشاء من عباده، فإنّه أعلم حيث يجعل رسالته.
ومن المحتمل أن يكون المراد من «الهداية» يسبّب هذا البعث، فإنّها من فضل الله على المؤمنين كما يدلّ عليه قوله( لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً ) (١) إلى آخره.
وفي بعض القراءات لمن منّ الله على المؤمنين(٢) ولا ريب أنّ إرسال الرسل وإنزال الكتب من ألطاف الله على عباده، وقد صرّح المتكلّمون بوجوب اللطف ـ أي ما يقرّب إلى الطاعات ويبعّد عن المعاصي ـ على الله تعالى.
__________________
(١) آل عمران : ١٦٤.
(٢) آل عمران : ١٦٤.
قال بعضهم : ومن الألطاف بعث الأنبياء ونصب الأولياء للاحتياج إليهم في انتظام المعاش لحصول الاجتماع المضطرّ إليه في بقاء النوع ؛ المستلزم لوقوع الفساد من غلبة دواعي الحسّ، فيقع الهرج والمرج ولا ينحسم ذلك إلّا بقانون يفيد قطع المنازعات بشارع متأيّد بالآيات القاهرة، ليحصل الانقياد الموجب للانتظام. انتهى.
وخالف الأشعريّ فذهب إلى أنّ اللطف لا يجب على الله ؛ إذ العقل لا يحكم بوجوب شيء عليه، فما يصدر عنه تعالى من هذه الأفعال فهو على سبيل التفضّل، وظاهر الآية وإن كان يساعده إلّا أنّ في الكلام في الردّ عليه محلّا آخر.
ومعنى «يؤتيه» يعطيه، وعطيّته لا تكون إلّا لمن له قابليّة واستعداد، والله لا يعطي إلّا مع المصلحة، ولا مصلحة قطعا في إعطاء من لا يستعد، ولا تتعلّق مشيّته تعالى بإعطاء من لا يستحق العطيّة ومن لا تصلح له.
وفي «حقائق القرآن» بعد ذكر هذه الآية قال الحسين : جاد الجواد بجوده لغير علّة وتفضّل بالتفضيل ؛ وتمّمه بالمنن، وغشّاه بالنعم ؛ إذ يقول( ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ ) فقطع بالمشيّة ومحق الأسباب فكان الكرم منه صرفا لا تمازجه العلل، ولا تكتسبه الحيل، جاد به في الدهور قبل إظهار الأمور إلى معرفته ومحبّته والاستقامة فيهما بنعت العبوديّة في مشاهدة الربوبيّة، يؤتي هذا الفضل من يشاء من عباده المصطفين في الأزل.
قال الجوزجانيّ : ذلك الفضل هو الأنس بالله ؛ إذا وجدوا نعمة الأنس نسوا كلّ نعمة دونه، وهو قوله( ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ ) انتهى. فتأمّل.
ومن المحتمل أن يكون المشار إليه بذلك هو التزكّي المفهوم من الكلام السابق، ويكشف عنه قوله تعالى في سورة «النور»( وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ما زَكى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً ) (١) .
والظاهر أنّ المراد بكونه ذا الفضل العظيم أنّه لا ينقص من عطائه شيء وإن أعطى ما أعطى، فإنّ عنده خزائن كلّ شيء كما قال( وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَما نُنَزِّلُهُ إِلَّا ) (٢) إلى آخره، وفي الحديث : لو أنّ أهل سماواتي وأهل أرضي أمّلوا جميعا ثمّ أعطيت كلّ واحد منهم مثل ما أمّل الجميع ما انتقص من ملكي مثل عضو ذرّة، وكيف ينقص ملك أنا قيّمه، فيا بؤسا للقانطين من رحمتي، ويا بؤسا لمن عصاني ولم يراقبني(٣) . انتهى.
ولعلّ النكتة في تعبير المسند إليه في قوله( ذلِكَ فَضْلُ اللهِ ) باسم الإشارة إلى البعيد تعظيم المشار إليه كما في قوله( الم ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ ) (٤) فنزل بعد الدرجة ورفعة المحلّ، منزلة بعد المسافة، ففيه إشارة إلى أنّ الرسالة منصب فوق جميع المناصب ؛ لا تناله يد كلّ أحد، ولا يدرك بالكسب لكونه موهبة عظيمة من عند الله، وقد أحسن من قال بالفارسية :
از رياضت كى توان الله شد |
كى توان موسى كليم الله شد |
قال التفتازانيّ : وقد يقصد به تعظيم المشير كقول الأمير لبعض حاضريه ذلك قال كذا. انتهى، فتأمل.
__________________
(١) النور : ٢١.
(٢) الحجر : ٢١.
(٣) الكافي ٢ : ٦٦.
(٤) البقرة : ١ ـ ٢.
وقد يقال : إنّ الآية تفيد الحصر وهو كما ترى، ضرورة أنّ كلّ ما يعطي الله عبده من رزق وغيره فهو من فضله تعالى عليه، وإلّا فالعبد من حيث هو لا يستحقّ شيئا كما فصّلناه في محلّ آخر.
وقد روى الطبرسيّ رحمه الله في المجمع : أنّه جاء الفقراء إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله فقالوا : يا رسول الله، إنّ للأغنياء ما يتصدّقون وليس لنا ما نتصدّق، ولهم ما يحجّون وليس لنا ما نحجّ، ولهم ما يعتقون وليس لنا ما نعتق؟ فقال صلّى الله عليه وآله : من كبّر الله مائة مرّة كان أفضل من عتق رقبة، ومن سبّح الله مائة مرّة كان أفضل من مائة فرس في سبيل الله يسرجها ويلجمها، ومن هلّل الله مائة مرّة كان أفضل الناس عملا في ذلك اليوم، إلّا من زاد. فبلغ ذلك الأغنياء فقالوه، فرجع الفقراء إلى النبي صلّى الله عليه وآله فقالوا : يا رسول الله، قد بلغ الأغنياء ما قلت فصنعوه؟ فقال صلّى الله عليه وآله :( ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ ) (١) انتهى. فيستفاد منه أنّ الفضل لا ينحصر في الرسالة، فليتأمّل.
و «المثل» في قوله تعالى :( مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) بمعنى الحال والصفة، كما في قوله تعالى :( مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ) (٢) وقوله :( فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ) (٣) .
__________________
(١) مجمع البيان، المجلّد ٥ : ٤٢٩ ـ ٤٣٠.
(٢) الرعد : ٣٥، ومحمّد : ١٥.
(٣) الأعراف : ١٧٦.
ويستعمل «المثل» بالكسر والسكون في هذا المعنى أيضا، وبالعكس، فيراد بـ «المثل» الشبيه بالآخر في صفة من الصفات، وكيف كان فقد شبّه الله حال علماء اليهود الّذين عرفوا صفات النبيّ صلّى الله عليه وآله المبعوث عليهم من التوراة، كما عرفوا أبناءهم، فأنكروه تعصّبا وحسدا من أنفسهم بحال الحمار الغير المنتفع بما عليه من الأسفار، قال الله :( فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكافِرِينَ ) (١) .
قال الرازيّ : اعلم أنّه تعالى بعد أن أثبت التوحيد والنبوّة وبيّن في النبوّة أنّه صلّى الله عليه وآله بعث إلى الأمّيّين، واليهود لمـــّـا أوردوا تلك الشبهة، وهي أنّه صلّى الله عليه وآله بعث إلى العرب خاصّة ولم يبعث إليهم بمفهوم الآية، أتبعه الله بضرب المثل للّذين أعرضوا عن العمل بالتوراة والإيمان بالنبيّ صلّى الله عليه وآله، والمقصود منه أنّهم لمـــّـا لم يعملوا بما في التوراة شبّهوا بالحمار، لأنّهم لو عملوا بمقتضاها لا نتفعوا بها ولم يوردوا تلك الشبهة، وذلك لأنّ فيها نعت الرسول صلّى الله عليه وآله والبشارة بمقدمه، والدخول في دينه، وقوله( حُمِّلُوا التَّوْراةَ ) أي حمّلوا العمل بما فيها، وكلّفوا القيام بها(٢) . انتهى.
وفي الكشّاف : شبّه اليهود ـ في أنّهم حملة التوراة وقرّاؤها وحفّاظ ما فيها، ثمّ إنّهم غير عاملين بها ولا منتفعين بآياتها، وذلك أنّ فيها نعت رسول الله صلّى الله عليه وآله والبشارة به ولم يؤمنوا به ـ بالحمار حمل أسفارا، أي
__________________
(١) البقرة : ٨٩.
(٢) التفسير الكبير ٣٠ : ٥.
كتبا كبارا من كتب العلم، فهو يمشي بها ولا يدري منها إلّا ما يمرّ بجنبيه وظهره من الكدّ والتعب، وكلّ من علم ولم يعمل بعلمه فهذا مثله وبئس المثل(١) . انتهى.
وقال الأصمعيّ : إنّ الأسفار جمع السفر، وهو الكتاب الكبير، لأنّه يسفر عن المعنى إذا قرئ، ونظيره شبر وأشبار ؛ شبّه اليهود ـ إذا لم ينتفعوا بما في التوراة، وهي دالّة على الإيمان لمحمّد صلّى الله عليه وآله ـ بالحمار الّذي يحمل الكتب العلميّة ولا يدري ما فيها. انتهى.
وقوله «يحمل» جملة حاليّة، فهي في محلّ النصب، وقد يقال : إنّها وصفيّة في محلّ الجرّ.
واعترض عليه باشتراط التنكير في الموصوف بالجمل، فإنّها نكرات، وردّ بأنّ «اللام» في الحمار للجنس، وهو نكرة كما في قوله :
ولقد أمرّ على اللئيم يسبّني
والحقّ جواز الوجهين.
و «اللام» في «القوم» إمّا للعهد الذكريّ وإمّا للجنس، فالمخصوص بالذمّ محذوف، أي مثلهم. وقد يقال : إنّ التقدير «بئس مثلا مثل القوم» كما في قولهم : «نعم رجلا زيد» فالمقصود أنّ كلّ من يحمل كلام الله ثمّ لا يعمل به فهو كالحمار.
وقد يقال : إنّ تشبيه العالم بالحمار سيّما في حمل الأسفار ليس من باب التحقير للعالم من حيث عدم عمله بعلمه، بل من حيث عدم مبالاته وعدم قبوله الحقّ، وبجهله مع كمال علمه ومعرفته، كما شبّه الله بالأنعام كلّ من لم
__________________
(١) الكشّاف ٤ : ٥٣٠.
يتعدّ نظره عن ظهور هذه الأجسام إلى عالم التدبّر في توحيده، ولم يرتق فكره عن عمارة هذه الهياكل والأبدان إلى عالم التصديق من حيث الدليل والبرهان في إثبات صفاته الجلاليّة والكماليّة، حيث قال :( لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها وَلَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ) (١) إلى طريق الحقّ لشؤم سيرتهم الفاسدة، وخبث سريرتهم الخاسرة.
ومورد الآية وإن خصّ بعلماء اليهود، ولكنّ المناط ـ وهو عدم العمل بالعلم ـ يعمّ جميع علماء السوء الّذين يتركون العمل بما يعلمون، وقد تواترت الأخبار بذمّهم من طرق الفريقين، ولا يخفى أنّ توفيق العمل بالعلم أيضا من فضل الله يؤتيه من يشاء، كما أنّ نفس العلم أيضا كذلك إذا كان المعلوم من علوم الآخرة، فلا يؤتى إلّا من عمل صالحا وتزكّى بالرياضات الشرعيّة، وقد أحسن من قال :
شكوت إلى [وكيع سوء](٢) حفظي |
فأرشدني إلى ترك المعاصي |
|
وقال : اعلم بأنّ العلم فضل |
وفضل الله لا يؤتاه عاص |
وقوله تعالى :( وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) إشارة إلى أنّ هؤلاء الّذين أخبروا برسالة هذا النبيّ صلّى الله عليه وآله في التوراة فأنكروه بعد بعثه،
__________________
(١) الأعراف : ١٧٩.
(٢) في الأصل : الوكيع قلّة.
فهم قد ظلموا أنفسهم وعلم الله بشقاوتهم من الأزل، فلا يتوقّع إيمانهم حيث لا يفعل الله بهم من الألطاف التّي يفعلها بالمؤمنين الّذين بها يهتدون إلى الحقّ، أولا يهديهم إلى الجنّة، فإنّ طريقها منحصرة في الإيمان بهذا النبيّ الأمّيّ العربيّ الناسخ بشريعته جميع الشرائع السالفة، ويمكن حمل الآية على العموم نظرا إلى الظاهر من إفادة الجمع المحلّى بـ «اللام» له، إذا لم يكن للعهد، فتأمّل.
وفي قوله تعالى :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ هادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِياءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ وَلا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَداً بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ) إشارة إلى أنّ المدّعي لا يقبل قوله بمجرّد الدعوى، بل لا بدّ له من إقامة البيّنة عليها، ودعوى محبّة الله وولايته من أعظم الدعاوى وأعلاها وأصعبها، فكيف يصغى إليها بمجرّد القول والتدليس؟!
قال في «مصباح الشريعة» : ومن ادّعى فيما لا يحلّ له فتح عليه أبواب البلوى، والمدّعي يطلب بالبيّنة لا محالة وهو مفلس فيفتضح(١) .
وفي الديوان العلويّ :
لا تخدعنّ فللمحبّ دلائل |
ولديه من نجوى الحبيب رسائل |
|
منها تنعّمه بما يبلى به |
وسروره في كلّ ما هو فاعل |
|
فالمنع منه عطيّة معروفة |
والفقر إكرام ولطف عاجل |
|
ومن الدلائل أن يرى متحفّظا |
متقشّفا في كلّ ما هو نازل |
|
ومن الدلائل أن تراه مشمّرا |
في غرقيين على شطوط الساحل |
__________________
(١) مصباح الشريعة : ٢٠٠.
ومن الدلائل زهده فيما يرى |
من دار ذلّ والنعيم الزائل |
|
ومن الدلائل أن يرى من عزمه |
طوع الحبيب وإن ألحّ العاذل |
|
ومن الدلائل أن يرى من شوقه |
مثل السقيم وفي الفؤاد غلائل |
|
ومن الدلائل أن يرى من أنسه |
مستوحشا من كلّ ما هو شاغل |
|
ومن الدلائل أن يرى متبسّما |
والقلب فيه مع الحنين بلابل |
|
ومن الدلائل ضحكه بين الورى |
والقلب محزون كقلب الثاكل |
|
ومن الدلائل أن يرى متمسّكا |
بسؤال من يحظى لديه السائل |
|
ومن الدلائل أن تراه مسافرا |
نحو الجهاد وكلّ فعل فاضل |
|
ومن الدلائل أن تراه باكيا |
إن قد رآه على قبيح عاقل |
|
ومن الدلائل أن تراه مسلّما |
كلّ الملوك إلى المليك العادل |
وعن الصادق عليه السلام : حبّ الله إذا أضاء على سرّ عبد أخلاه من كلّ شاغل، وكلّ ذكر سوى الله عنده ظلمة، والمحبّ أخلص الناس سرّا، وأصدقهم قولا، وأوفاهم عهدا، وأزكاهم عملا، وأصفاهم ذكرا، وأعبدهم نفسا، تتباهى الملائكة عنده مناجاته، وتفتخر برؤيته، وبه يعمر الله بلاده، وبكرامته يكرم الله عباده، ويعطيهم إذا سألوه بحقّه، ويدفع عنهم البلايا برحمته، فلو علم الخلق ما محلّه عند الله ومنزلته لديه ما تقرّبوا إلى الله إلّا بتراب قدميه(١) إلى آخره. انتهى.
ولا ريب أنّ من علامات محبّة الله الاشتياق إلى الموت، فإنّ فيه لقاء الله، ومن أحبّ الله أحبّ لقاءه، ومن أحبّ لقاءه أحبّ الموت، ومن هنا قال عليّ
__________________
(١) مصباح الشريعة : ١٩٢.
عليه السلام : والله لابن أبي طالب أشوق إلى الموت من الطفل إلى ثدي أمّه(١) .
وروي أنّه عليه السلام يطوف بين صفّين في غلالة، فقال له ابنه الحسن عليه السلام : ما هذا بزيّ المحاربين، فقال : يا بنيّ لا يبالي أبوك على الموت سقط أم عليه سقط الموت(٢) .
وروي أنّه كان الحسين عليه السلام وبعض من معه من خصائصه تشرق ألوانهم، وتهدأ جوارحهم، وتسكن نفوسهم، فقال بعضهم لبعض : انظروا إليه فلا يبالي بالموت؟ فقال عليه السلام : صبرا يا بني الكرام، فما الموت إلّا قنطرة تعبر بكم عن البؤس والضرّاء إلى الجنان الواسعة، والنعيم الدائمة، فأيّكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر، وهؤلاء أعداؤكم كمن ينتقل من قصر إلى سجن وعذاب، إنّ أبي حدّثني بذلك عن جدّي رسول الله صلّى الله عليه وآله : أنّ الدنيا سجن المؤمن، وجنّة الكافر(٣) ، فالموت جسر هؤلاء إلى جنانهم، وجسر هؤلاء إلى جحيمهم، ما كذبت ولا كذّبت(٤) . انتهى.
وعن عليّ بن الحسين عليهما السلام : ما الموت للمؤمن إلّا كنزع ثياب وسخة قملة، وفكّ قيود وأغلال ثقيلة، والاستبدال بأفخر الثياب وأطيبها روائح، وأوطأ المراكب، وآنس المنازل، وللكافر كخلع ثياب فاخرة والنقل
__________________
(١) نهج البلاغة : ٥٢ الخطبة ٥.
(٢) نهج البلاغة : ٩١ الخطبة ٥٥.
(٣) الفقيه ٤ : ٣٦٢.
(٤) معاني الأخبار : ٢٨٨.
من منازل أمينة(١) والاستبدال بأوسخ الثياب وأخشنها، وأوحش المنازل، وأعظم العذاب(٢) .
وروي أنّه قيل لمحمّد بن عليّ الرضا عليه السلام : ما بال هؤلاء المسلمين يكرهون الموت؟ قال : لأنّهم جهلوه فكرهوه، ولو عرفوه وكانوا من أولياء الله عزّ وجلّ حقّا لأحبّوه، ولعلموا أنّ الآخرة خير لهم من الدنيا.
ثمّ قال : يا [أبا] عبد الله، ما بال الصبيّ والمجنون يمتنع من الدواء المشفي لبدنه والنافي للألم عنه؟ فقال : لجهلهم بنفع الدواء، قال عليه السلام : والّذي بعث محمّدا بالحقّ! إنّ من استعدّ للموت حقّ الاستعداد فهو أنفع له من هذا الدواء، وهذا التعالج، إنّهم لو علموا ما يؤدّي إليه الموت من النعيم لاستدعوه أشدّ استدعاء(٣) .
وروي أنّه عليه السلام دخل على مريض من أصحابه وهو يبكي ويجزع من الموت، فقال له : يا عبد الله، تخاف الموت لأنّك لا تعرفه، أرأيتك إذا وسخت وتقذّرت ما عليك من الوسخ والقذارة وأصابك آكلة وقرح وجرب أما تريد أن تدخل حمّاما فتغسل ذاك عنك، أو ماء في حمّام يزيل عنك ذلك كلّه، أو تكره أن لا تدخله فيبقى عليك؟ فقال : بلى يا ابن رسول الله. قال : فذلك الموت، وهو ذلك الحمّام، وهو آخر ما يبقى عليك من تمحيص ذنوبك وينقّيك من سيّئاتك، فإذا أنت وردت عليه وجاوزته
__________________
(١) في المعاني : أنيسة.
(٢) معاني الأخبار : ٢٨٩.
(٣) معاني الأخبار : ٢٩٠.
نجوت من كلّ همّ وغمّ وأذى إلى سرور وفرح. فسكن الرجل ونشط واستسلم وغمّض عين نفسه ومضى لسبيله(١) .
وبالجملة : الأخبار في هذا الباب متكاثرة متظافرة، بل متواترة، فيكون تمنّي الموت والتخلّص عن العلائق الجسمانيّة والأغلال والسلاسل المرتّبة على الحياة الدنيويّة من الدلائل الواضحة على محبّة الله وكمال معرفته، ومن هنا لمـــّـا ادعت اليهود أنّهم أحبّاء الله وأولياؤه، وأنّ الجنّة خالصة لهم، وأنّ الله لا يعذّبهم، ولو عذّبهم لكان ذلك في أيّام معدودات ؛ كما أخبر الله بذلك كلّه عنهم في كتابه ردّ الله عليهم وكذّبهم في هذه السورة بما عرفته، وفي سورة «البقرة» بقوله :( قُلْ إِنْ كانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللهِ خالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى حَياةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَما هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ ) (٢) .
فإن قلت : قد ورد النهي عن تمنّي الموت، فقد روى الشيخ في «أماليه» بإسناده عن أمّ الفضل قالت : دخل رسول الله صلّى الله عليه وآله على رجل يعوده وهو شاكّ فتمنّى الموت، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا تتمنّ الموت فإنّك إن تك محسنا تزداد حسنا إلى إحسانك، وإن تك مسيئا فتؤخّر لتستعتب(٣) . انتهى.
__________________
(١) معاني الأخبار : ٢٩٠.
(٢) البقرة : ٩٤ ـ ٩٦.
(٣) الأمالي، للطّوسي : ٣٨٥.
وروي في بعض كتب العامّة : إنّ رسول الله قال : لا يتمنّينّ أحدكم الموت لضرّ نزل به، وإن كان ولا بدّ فليقل : أللّهمّ أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني ما كانت الوفاة خيرا لي(١) . انتهى.
فالمنهيّ عنه كيف يصلح أن يكون دليلا على محبّة الله وولايته؟!
قلت : بعد الغضّ عن ضعف سند الخبرين ومخالفتهما لظاهر القرآن، أنّ تمنّي الموت على قسمين :
أحدهما : أن يكون للاشتياق إلى الدار الآخرة، والوصول إلى لقاء الحقّ، والجلوس على بساط قربه، كما هو غاية آمال المشتاقين، ومنتهى أماني العارفين، وقد قال الله في «الحديث القدسيّ» : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر(٢) . وهذا التمنّي ممدوح.
وثانيهما : أن يكون من باب الجزع وترك الصبر على مصائب الدنيا، وعدم الرضا بالقضاء والتسليم لأمر الله وقدره، كما هو الغالب في الناس. ومن هنا قال الشاعر :
ألا موت يباع فأشتريه |
فهذا العيش ما لا خير فيه |
|
ألا رحم المهيمن روح عبد |
تصدّق بالوفاة على أخيه |
وهذا التمنّي مذموم، والنهي محمول عليه.
فإن قلت : قد ذكرت أنّ أولياء الله يتمنّون الموت ولا يكرهونه بقلوبهم،
__________________
(١) بحار الأنوار ٧٩ : ١٧٦.
(٢) عوالي اللئالي ٤ : ١٠١.
بل يشتاقون إليه، فما الوجه فيما رواه في «الكافي» عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر : قال : لمـــّـا أسري بالنبيّ صلّى الله عليه وآله قال : يا ربّ، ما حال المؤمن عندك؟
قال : يا محمد، من أهان لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي، وما تردّدت في شيء [أنا فاعله] كتردّدي في وفاة المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، وإنّ من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلّا الغنى، ولو صرفته إلى غير ذلك لهلك(١) إلى آخره. وقريب منه روايات اخر.
ففي رواية حمّاد بن بشير، عن الصادق عليه السلام : وما تردّدت في شيء أنا فاعله كتردّدي عن موت المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته(٢) .
وفي رواية معلّى بن خنيس عنه عليه السلام : قال الله عزّ وجلّ : من استذلّ عبدي المؤمن فقد بارزني بالمحاربة، وما تردّدت في شيء أنا فاعله تردّدي في عبدي المؤمن، أنا أحبّ لقاءه فيكره الموت، فأصرفه عنه، وإنّه ليدعوني في الأمر فأستجيب له بما هو خير له(٣) . انتهى.
فهذه الروايات صريحة في أنّ المؤمن يكره الموت، والموت لقاء الله، فيلزم منه أنّه سبحانه يكره لقاءه، لما روي عن النبيّ صلّى الله عليه وآله، أنّه قال : من أحبّ لقاء الله أحبّ الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه(٤) . وهذا
__________________
(١ و ٢) الكافي ٢ : ٣٥٢.
(٣) الكافي ٢ : ٣٥٤.
(٤) مصباح الشريعة : ١٧١.
ينافي كونه مؤمنا كما لا يخفى.
قلت : ليس في هذه الأخبار أنّ المؤمن يكره لقاء الله، وإنّما المذكور فيها أنّه يكره الموت، والموت ليس نفس لقاء الله، بل هو موصل إليه.
قال المحقّق النراقيّ رحمه الله في «مشكلات العلوم» : فكراهته من حيث الألم الحاصل منه لا تستلزم كراهة لقاء الله. انتهى. توضيحه : أنّ الموت من حيث اشتماله على الآلام والسكرات يكرهه الإنسان بطبعه، والمكره بالطبع قد يكون مطلوبا محبوبا بالنظر إلى فائدته وخاصيّته المرتّبة عليه كالفصد والحجامة، فإنّهما في ذاتهما مؤلمان لا يلائمان طبع الإنسان، ولكنّهما مطلوبان للعاقل يعطي بإزائهما أجرة، لأنّهما يدفعان ما ببدنه من المرض، وإن كان الأطفال والمجانين يهربون من الفصّاد والحجّام، ويجزعون من عملهما، وكذا حال المؤمن، فإنّه بحسب طبعه الحيوانيّ يتألّم من سكرات الموت، وأمّا بحسب رتبة الإيمان فهو مشتاق إلى الموت، لكونه وسيلة إلى الوصول إلى لقاء الحقّ.
قال المحدّث الكاشانيّ في «الوافي» : فكراهة الموت لا تنافي لقاء الله، مع أنّه قد ورد : أنّ حال الاحتضار يحبّب الله إلى المؤمن لقاءه حتّى يشتاق إلى الموت، انتهى.
ويحتمل أن يكون الضمير المنصوب في قوله «فأصرفه عنه» راجعا إلى ألم الموت لا نفس الموت، وفي «المشكلات» : إنّ كراهة الموت غير موقّت بوقت، وكذا حبّ لقاء الله، فيحمل الأوّل على ما قبل الاحتضار وعدم مشاهدته ما أعدّ الله له من النوازل الرفيعة، والنعم الكثيرة، والثاني على حال
الاحتضار ومعاينته ما يحبّ، ويحمل كراهة لقاء الله على هذه الحالة لغير المؤمن، فإنّه يعاين ما يسوؤه فيكره الموت. انتهى، فتأمّل.
وعلى هذه الأخبار سؤال آخر، وهو أنّ التردّد لا يجوز إلّا على الجاهل، فلا معنى لتردّد الله سبحانه؟
وقد أجيب عنه تارة بأنّ المراد تردّد الملائكة الموكّلين على الموت.
وأخرى : بأنّ في الكلام إضمارا، فإنّ التقدير : ما تردّدت لو جاز لي التردّد.
وثالثة : بأنّ في الكلام استعارة تمثيليّة عن الإكرام والاحترام.
ورابعة : بأنّ المراد تشبيه ما يظهره الله للمؤمن عند احتضاره من اللطف والإكرام والبشارة، بحيث يزيل عنه كراهة الموت بمعاملة من يريد أن يؤلّم حبيبه بما يترتّب عليه منافع عظيمة فيتردّد في فعله، وفي بعض هذه الوجوه ما لا يخفى، ولسنا نحن الآن بصدد شرح هذا المطلب، وإنّما أشرنا إليه استطرادا، فلنرجع إلى ما كنّا فيه.
فنقول : لا ريب في أنّ الوليّ لله المحبّ له شائق إلى لقائه، فلا يكره الموت، بل يتمنّاه، فاليهود المدّعون لهذا المقام الّذين لا يتمنّون الموت أبدا كاذبون في هذه الدعوى، قال عيسى ابن مريم عليه السلام : ويلكم يا عبيد الدنيا، من أجل نعمة زائلة وحياة منقطعة تفرّون من الله وتكرهون لقاءه، فكيف يحبّ الله لقاءكم وأنتم تكرهون لقاءه؟! فإنّما يحبّ الله لقاء من يحبّ لقاءه، وكيف تزعمون أنّكم أولياء الله من دون الناس وأنتم تفرّون من الموت وتعتصمون بالدنيا؟! فماذا يغني عن الميّت طيب ريح حنوطه،
وبياض أكفانه، وكلّ ذلك في التراب، كذلك لا يغني عنكم بهجة دنياكم الّتي زيّنت لكم وكلّ ذلك إلى سلب وزوال، ماذا يغني عنكم نقاء أجسادكم وصفاء ألوانكم وإلى الموت تصيرون، وفي التراب تنسون، وفي ظلمة القبر تغمرون(١) إلى آخره. انتهى.
وفي تفسير «حقائق القرآن» بعد ذكر الآية : جرّب الله تعالى شأنه المدّعين في محبّته بالموت، وأفرز الصادقين من بينهم لما غلب عليهم من شوق الله وحبّ الموت، فتبيّن صدق الصادقين هاهنا من كذب الكاذبين ؛ إذ الصادق يختار اللحوق إليه، والكاذب يفرّ منه. قال صلّى الله عليه وآله : من أحبّ لقاء الله(٢) إلى آخره.
قال الجنيد : المحبّ يكون مشتاقا إلى مولاه، فهو يتمنّى الموت أبدا وذلك قوله :( إِنْ زَعَمْتُمْ ) إلى آخره. انتهى.
لا يقال : إنّ الموت عدم والعاقل لا يختار العدم على الوجود.
لأنّا نقول : أوّلا نمنع كونه عدما، لأنّ الله نصّ في كتابه بأنّه( خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ ) (٣) .
وقال الباقر عليه السلام : الحياة والموت خلقان من خلق الله، فإذا جاء الموت فدخل في الإنسان لم يدخل في شيء إلّا وقد خرجت منه الحياة(٤) .
وثانيا : إنّ الحياة الحقيقيّة في هذا الموت كما قيل :
__________________
(١) تحف العقول : ٥٠٥.
(٢) مصباح الشريعة : ١٧١.
(٣) الملك : ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٢٥٩.
إذا شئت أن تحيا فمت عن علائق |
عن الحسّ خمسا ثمّ عن مدركاتها |
وقال بعضهم :
اقتلوني يا ثقاتي إنّ في قتلي حياتي |
ومماتي في حياتي وحياتي في مماتي |
وفي التنزيل :
( وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ) (١) .
وفي الحديث : إنّما خلقتم للبقاء لا للفناء(٢) . فالفاني من الإنسان هو جسده وبدنه لا نفسه وحقيقته، بل قيل : إنّ الضمير في قوله( كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ) (٣) راجع إلى نفس الشيء، يعني : إنّ كلّ شيء فان سوى حقيقته.
وبالجملة : لا تكون الحياة الدنيويّة الزائلة أشرف من الموت الّذي هو قنطرة إلى الحياة الأبديّة الباقية.
وقد حكى بعض أنّه رأى شابّا مغلو لا ينظر إلى السماء ويبكي ويقول بعد جملة من الكلمات : آه آه من حيّ يحسد الأموات، آه آه من حياة شرّ من الممات، فويل ثمّ ويل لي، وطوبى ثمّ طوبى لإخواني الّذين لم يخلقوا، وهنيئا لأقربائي الّذين لم يوجدوا واستراحوا في فسحة العدم من تعب الحياة ؛ فقلت : يا مجنون، ألم تعلم أنّ الوجود أشرف من العدم؟ فقال : هل خلوت منذ خلقت عن مكاره الدنيا؟ قلت : لا. قال : فهل أنت على يقين
__________________
(١) آل عمران : ١٦٩.
(٢) غرر الحكم : ١٣٣.
(٣) القصص : ٨٨.
بالنجاة عن عقاب العقبى؟ قلت : لا. قال : ويحك يا مطرود، فأيّ شرف في هذا الوجود؟ أنت بهذا الفهم عاقل، وأنا مع هذه اليقظة غافل؟!
قوله : «هادوا» أي صاروا يهودا كـ «تهوّدوا»، واليهود على ما قيل تنسب إلى يهوذا بن يعقوب.
وقيل : من «هاد» «يهود»، إذا سكن، ومنه قوله تعالى :( إِنَّا هُدْنا إِلَيْكَ ) (١) أي سكنّا إلى أمرك.
وقيل : من «هاد» بمعنى «تاب» ورجع، ولمّا قال قوم موسى هذا القول، سمّوا باليهود.
وفي «مجمع الطريحيّ» : اليهود قوم موسى، وهو اسم جنس لا ينصرف للعلميّة والتأنيث، لأنّه يجري في كلامهم مجرى القبيلة(٢) .
قال الزمخشريّ : والأصل في «يهود» ومجوس أن يستعملا بغير «لام» التعريف، لأنّهما علمان خاصّان لقومين كقبيلتين، وإنّما جوّزوا تعريفهما بـ «اللام» لأنّه أجري يهودي ويهود مجرى شعيرة وشعير(٣) . انتهى.
و «الزعم» يستعمل في الظنّ وفي الاعتقاد مطلقا سواء كان المعتقد حقّا أو باطلا، إلّا أنّ استعماله في الثاني أغلب ؛ كما في قوله :( هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ ) (٤) وقوله :( زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا ) (٥) .
وعن الأزهريّ : إنّ أكثر ما يكون «الزعم» فيما يشكّ ولا يتحقّق.
__________________
(١) الأعراف : ١٥٦.
(٢ و ٣) مجمع البحرين ٤ : ٤٤٢ (هود).
(٤) الأنعام : ١٣٦.
(٥) التغابن : ٧.
وعن المرزوقيّ : إنّ أكثر ما يستعمل فيما كان باطلا وفيه ارتياب.
وقيل : إنّ «زعم» مطيّة الكذب.
وقيل : إنّه خبر لا يدرى أحقّ هو أم باطل.
وروي أنّ كلّ زعم في القرآن كذب. فليتأمّل.
و «لن» و «لا» للنفي، إلّا أنّ «لن» في سورة «البقرة» لتأكيد النفي أو تأبيده، وقد صرّح بالتأبيد في الآيتين فلا منافاة.
و «الباء» في «بما قدّمت» للسببيّة.
و «ما» موصوليّة حرفيّة أو اسميّة، فيرجع المعنى إلى أنّ عدم تمنّيهم للموت لعدم اطمئنانهم بالنجاة من النار، حيث ارتكبوا أعمالا سيّئة تنافي دعواهم المحبّة والولاية.
قال في «الكشّاف» : وقد قال لهم رسول الله صلّى الله عليه وآله : والّذي نفسي بيده، لا يقولها أحد منكم إلّا غصّ بريقه، فلو لا أنّهم كانوا موقنين بصدق رسول الله صلّى الله عليه وآله لتمنّوا، ولكنّهم علموا أنّهم لو تمنّوا لماتوا من ساعتهم ولحقهم الوعيد، فما تمالك أحد منهم أن يتمنّى، وهو أحدى المعجزات(١) ، انتهى.
وقوله :( وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ) برهان على صدق قوله( وَلا يَتَمَنَّوْنَهُ ) فإنّ التمنّي أمر قلبيّ باطنيّ، وعلمه تعالى بالسرائر ممّا لا يصحّ إنكاره لمن اعتقد بوجود الصانع تعالى، وإنّما لم يقل «بهم» ووضع الظاهر مقام الضمير للإيماء إلى أنّ هؤلاء قد ظلموا رسول الله صلّى الله عليه وآله في كتمانهم ما
__________________
(١) الكشّاف ٤ : ٥٣١.
عرفوه بقلوبهم من النبوّة والرسالة، ففي ذلك تهديد لهم بأنّ الله يعذّبهم العذاب المعدّ للظالمين، وقد قال :( إِنَّا أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ ناراً أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها ) (١) إلى آخره.
وقوله :( قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) تهديد آخر وتصريح بأنّ الفرار من الموت لا ينفعهم أصلا كما يشاهدونه، وقد قال :( كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ ) (٢) وقال :( أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ) (٣) وقال :( فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ) (٤) وقال عليّ عليه السلام :
أشدد حياز يمك للمو |
ت فإنّ الموت لاقيكا |
|
ولا تجزع من المو |
ت إذا حلّ بواديكا(٥) |
وقال أيضا :
تزوّد من الدّنيا فإنّك راحل |
وبادر فإنّ الموت لا شكّ نازل(٦) |
وقال أيضا :
باتوا على قلل الأجبال تحرسهم |
غلب الرجال فلم تنفعهم القلل |
|
واستنزلوا بعد عزّ عن معاقلهم |
إلى مقابرهم يا بئس ما نزلوا |
__________________
(١) الكهف : ٢٩.
(٢) آل عمران : ١٨٥، والأنبياء : ٣٥، والعنكبوت : ٥٧.
(٣) النساء : ٧٨.
(٤) الأعراف : ٣٤، والنحل : ٦١.
(٥) ديوان الإمام عليّ عليه السلام : ٣٠٨.
(٦) ديوان الإمام عليّ عليه السلام : ٣١٥.
ناداهم صارخ من بعد ما دفنوا |
أين الأسرّة والتيجان والحلل |
|
أين الوجوه الّتي كانت محجّبة |
من دونها تضرب الأستار والكلل |
|
فأفصح القبر عنهم حين ساءلهم |
تلك الوجوه عليها الدود ينتقل |
|
قد طال ما أكلوا فيها وقد شربوا |
فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا |
|
وطال ما كنزوا الأموال وادّخروا |
فخلّفوها على الأعداء وارتحلوا |
|
وطال ما شيّدوا دورا لتحصنهم |
ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا |
|
أضحت مساكنهم وحشا معطّلة |
وساكنوها إلى الأجداث قد رحلوا(١) |
إلى آخر الأبيات المذكورة في «الديوان العلويّ».
وقد حكى «ابن خلّكان في تاريخه» : إنّه قد سعي بعليّ بن محمّد الجواد عليهما السلام إلى المتوكّل العبّاسيّ وقيل له : إنّ في منزله سلاحا وكتبا وغيرها من شيعته، وأوهموه أنّه يطلب الأمر لنفسه، فوجّه إليه بعدّة من الأتراك ليلا فهجموا عليه في منزله على غفلة، فوجدوه وحده في بيت مغلق وعليه مدرعة من شعر، وعلى رأسه ملحفة من صوف، وهو مستقبل القبلة يترنّم بآيات من القرآن في الوعد والوعيد، وليس بينه وبين الأرض بساط إلّا الرمل والحصى، فأخذ على هذه الصورة الّتي وجد عليها، وحمل إلى المتوكّل في جوف الليل، فمثل بين يديه والمتوكّل يستعمل الشراب وفي يده كأس، فلمّا رآه أعظمه وأجلسه إلى جانبه، فناوله الكأس الّتي كانت بيده، فقال عليه السلام : يا أمير المؤمنين ما خامر لحمي ودمي قطّ، فأعفني عنه! فأعفاه وقال : أنشدني شعرا أستحسنه، فقال : إنّي لقليل الرواية في
__________________
(١) ديوان الإمام عليّ عليه السلام : ٣٢١.
الشعر، فقال : لا بدّ أن تنشدني شيئا، فأنشده هذه الأبيات، فأشفق كلّ من حضر على عليّ بن محمّد عليه السلام فبكى المتوكّل بكاء طويلا حتّى بلّت دموعه لحيته، وبكى من حضره، وأمر برفع الشراب، ثمّ قال : يا أبا الحسن، أعليك دين؟ قال : نعم ؛ أربعة آلاف دينار، فأمر بدفعها إليه وردّوه إلى منزله مكرّما(١) .
وحكى قريبا من ذلك القزوينيّ في «حياة الحيوان»والسيّد هاشم في«مدينة المعاجز».
قوله : ثمّ يردّون( إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ ) أي يرجعون إلى الله الّذي يعلم ما هو غيب عندكم، وما هو مشهود لديكم، وإلّا فالغيب والشهادة عنده سواء.
قوله :( ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ ) إلخ ؛ أي يخبركم بعواقب أعمالكم، ومساوئ أفعالكم، فويل لمن نسي ذلك اليوم فلم يتدارك ذنوبه بالتوبة، ولم يحاسب نفسه من قبل أن تحاسب.
قال المسيح عليه السلام : يا علماء السوء، لا تحدّثوا أنفسكم أنّ آجالكم يستأخر من أجل، أنّ الموت لم ينزل بكم، فكأنّه قد حلّ بكم فأطعنكم، فمن الآن فاجعلوا الدعوة في آذانكم، ومن الآن فنوحوا على أنفسكم، ومن الآن فابكوا على خطاياكم، ومن الآن فتجهّزوا وخذوا أهبتكم وبادروا التوبة إلى ربّكم، بحقّ أقول لكم ؛ إنّه كما لا ينظر المريض إلى طيب الطعام فلا يلتذّه مع ما يجده من شدّة الوجع، كذلك صاحب الدنيا لا يلتذّ بالعبادة ولا
__________________
(١) انظر : بحار الأنوار ٥٠ : ٢١١.
يجد حلاوتها مع ما يجد من حبّ المال، وكما يلتذّ المريض بنعت الطبيب العالم بما يرجو فيه من الشفاء، فإذا ذكر مرارة الدواء وطعمه كدر عليه الشفاء، كذلك أهل الدنيا يلتذّون ببهجتها وأنواع ما فيها، فإذا ذكروا فجأة الموت كدّرها عليهم وأفسدها.
بحقّ أقول لكم ؛ إنّ كلّ الناس يبصر النجوم ولكن لا يهتدي بها إلّا من يعرف مجاريها ومنازلها، وكذلك تدرسون الحكمة ولكن لا يهتدي بها منكم إلّا من عمل بها.
ويلكم يا عبيد الدنيا، نقّوا القمح وطيّبوه وأدقّوا طعمه يهنئكم أكله، كذلك فأخلصوا الإيمان وأكملوه تجدوا حلاوته.
بحقّ أقول لكم ؛ لو وجدتم سراجا يتوقّد بالقطران في ليلة مظلمة لاستضأتم به فلم يمنعكم ريح قطرانه، كذلك ينبغي لكم أن تأخذوا الحكمة ممّن وجدتموها معه، ولا يمنعكم منه سوء رغبته فيها.
ويلكم يا عبيد الدنيا، لا كحلماء تعقلون، ولا كحكماء تفقهون، ولا كعلماء تعلمون، ولا كعبيد أتقياء، ولا كأحرار كرام، توشك الدنيا أن تقلعكم من أصولكم فتقلبكم على وجوهكم، ثمّ تكبّكم على مناخركم، ثمّ تأخذ خطاياكم بنواصيكم حتّى تسلمكم إلى الملك الديّان عراة فرادى ؛ فيجزيكم بسوء أعمالكم.
بحقّ أقول لكم ؛ لا تدركون شرف الآخرة إلّا بترك ما تحبّون، فلا تنتظروا
بالتوبة غدا، فإنّ دون غد يوما وليلة قضى الله فيما يغدو ويروح(١) إلى آخره. انتهى.
ولمّا أرشد الله سبحانه عباده إلى التوحيد الّذي هو الأصل الأوّل من أصول الدين، وإلى رسالة محمّد صلّى الله عليه وآله الّتي هي من الأصل الثاني منها أي النبوّة المطلقة، وذمّ اليهود على ترك متابعته والإيمان به صلّى الله عليه وآله، وكذّبهم في دعواهم محبّة الله وولايته، خاطب المؤمنين خطاب عناية ولطف، وأرشدهم إلى فرع جليل من فروع الدين، وهو «صلاة الجمعة» فقال :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) .
قال الشهيد الثاني رحمه الله في آخر رسالة أفردها لوجوب صلاة الجمعة : اعلموا معاشر إخواننا المسلمين ؛ أعاننا الله وإيّاكم على طاعته، وأخذ بنواصينا إلى محبّته، وما يوجب الفوز لقرب حضرته ؛ أنّ صلاة الجمعة من أعظم فرائض الإسلام، وأفضل العبادات بعد الإيمان، خصّ الله بها هذه الأمّة الكريمة، وجعلها في ذلك اليوم الشريف من أجلّ مننه الجسيمة، جامعة بين وظيفة الذكر والصلاة والوعظ، واستماعها الموجب لصفاء القلوب، والانبعاث على التقوى، والبعد عن معصية الله، قد خصّ الله كلّ فرقة بيوم من الأسبوع يتقرّب فيه إليه بما شرعه لهم من الدين، وجعل هذه الصلاة في هذا اليوم من خاصّة المسلمين، وقد خصّها الله مع ذلك بالحثّ العظيم المؤكّد عليها بما
__________________
(١) مجموعة ورّام ١ : ١٧٥.
لم يفعله بغيرها من العبادات، فقال سبحانه في محكم كتابه :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ ) إلى آخره.
وفيها ضروب من التوكيد لا يقتضي الآن بسطه لكثرته ودقّة مأخذه عمّا يليق بهذا المكان ؛ لا تخفى على من له مسلك بحقائق الكلام، وأمر النبيّ صلّى الله عليه وآله بقراءة هذه السورة يوم الجمعة في سائر الصلوات ؛ خصوصا صلاة الجمعة ليبتدر السامع لهذا الأمر، وينبعث على العمل بمقتضاه، وأعاد التوكيد عليها في سورة «المنافقين» المأمور بقراءتها فيها أيضا.
فقال جلّ من قائل في سورة «المنافقين» بعد أن سمّى هذه الصلاة «ذكر الله» في سورة «الجمعة» وأمر بها، ناهيا عن التهاون بها في السورة الأخرى( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ ) (١) .
فتأمّل كيف جمع بين الأمر بفعلها والحثّ عليه في السورة الأولى، ثمّ شفعه بالنهي عن الاشتغال عنها، والتهديد على تركها في السورة الثانية، ووصف التارك لها بالخسران الّذي [وصف] به الكافرين والظالمين في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، وفي هذا كفاية للمستبصر وبلاغ للمتدبّر.
وقال :( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى ) (٢) فخصّ الصلاة الوسطى بالأمر بالمحافظة عليها من بين الصلوات، والّذي عليه المحقّقون
__________________
(١) المنافقون : ٩.
(٢) البقرة : ٢٣٨.
أنّها «صلاة الظهر» في غير يوم الجمعة، وفيه هي «الجمعة» بل قال جماعة : إنّها هي «الجمعة» لا غير(١) إلى آخره. انتهى.
ولا ريب في وجوب هذه الصلاة في زمان حضور النبيّ صلّى الله عليه وآله والإمام المعصوم مع اجتماع سائر الشروط المقرّرة في الفقه، وإنّما اختلف الأصحاب في حكمها في زمن الغيبة على أقوال، أظهرها عندي هو الحرمة، وقد أفردنا لذلك رسالة سمّيناها بـ «مغانم المجتهدين».
والمراد بـ «النداء» هو الأذان وب «الصلاة» صلاة الجمعة باتّفاق المفسّرين، وقد دلّت عليه جملة من روايات المعصومين عليهم السلام، ولو لا ذلك لحملت على مطلق الصلاة. فتأمّل.
قوله :( مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ) بضمّ «الميم» كما في لغة الحجاز، وفتحها كما في لغة تميم، وسكونها كما في لغة عقيل، ويسمّى قبل مجيء الإسلام بـ «يوم العروبة» بفتح «العين» المهملة وضمّ «الراء» كذلك.
قيل : سمّي هذا اليوم بـ «الجمعة» لاجتماع المسلمين فيه لإقامة صلاة الجمعة.
وقيل : لأنّه فرغ من خلق الخلق في هذا اليوم.
ويقال : إنّ أوّل من سمّاه بهذا الاسم هو «كعب بن لؤيّ» وقد كان قبل ذلك اسمه العروبة.
وقيل : معنى «يوم الجمعة» يوم الفوج المجموع، أو يوم الوقت الجامع.
وفي بعض الأخبار : سمّيت «الجمعة» جمعة، لأنّ الله جمع فيها خلقه
__________________
(١) الرسائل، للشهيد الثاني : ٩٨.
لولاية «محمّد صلّى الله عليه وآله» ووصيّه في الميثاق، فسمّاه يوم الجمعة.
وقد يسمّى «يوم المزيد» لما فيه من زيادة كرامات الله لأهل الجنّة في الآخرة.
وقد روي عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول : أتاني جبرئيل وفي كفّه مثل المرآة المصفيّة ـ ويروى كالمرآة البيضاء ـ فيها كالنكتة السوداء، قلت : ما هذه الّتي في يدك؟ قال : هذه «الجمعة»، قلت : وما الجمعة؟ قال : لكم فيها خير قسّم قلت : وما لنا فيها؟ قال : تكون عيدا لك ولأمّتك من بعدك، فيكون اليهود والنصارى تبعا لكم، ولكم فيها ساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله خيرا له هو له قسّم إلّا أعطاه إيّاه، أو ليس له قسما إلّا ذخر له عنده ما هو أفضل منه، أو يتعوّذ من شرّ هو عليه مكتوب إلّا فكّ عنه ما هو أعظم منه، وهو عندنا سيّد الأيّام، ونحن نسمّيه «يوم المزيد»، قلت : وممّ ذلك؟ قال : إنّ الربّ تبارك وتعالى اتّخذ في الجنّة واديا أفيح من مسك أبيض، وإذا كان يوم الجمعة وهو «يوم المزيد» نزل الربّ تعالى من علّيّين على كرسيّه ثمّ حفّ الكرسيّ بمنابر من ذهب مكلّل بالدرّ، ويجيء النبيّون يجلسون على تلك المنابر، ثمّ حفّت المنابر بكراسيّ من نور، ثمّ يجيء الصدّيقون والشهداء حتّى يجلسوا على تلك الكراسيّ، ثمّ ينزل أهل الغرف حتّى يجلسوا على كثبان المسك ـ ويروى على النمارق ـ ثمّ يتجلّى لهم الربّ فيقول لهم : أنا الّذي صدّقتكم وعدي، وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محلّ كرامتي فاسألوني فيسألونه الرضا، فيشهدهم أنّي قد رضيت عنكم، فيسألونه حتّى تنتهي رغباتهم، ثمّ يفتح لهم ما لم يخطر على قلب بشر، ولم
تسمعه أذن، ولم تره عين، وذلك مقدار منصرفهم عن الجمعة، ثمّ يرفع الربّ عن كرسيّه ويرتفع النبيّون والصدّيقون والشهداء، ثمّ يرجع أهل الغرف إلى غرفهم في جوف درّة بيضاء لا فصم فيها ولا وصم، أو ياقوتة حمراء، أو زبرجدة خضراء، أو مثل ذلك، فيها أنهار مطّردة، وثمارها متدلّية منها، فيها أزواجهم وخدمهم فليسو إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا فيه من الكرامة، ولذا سمّي «يوم المزيد» وفيه تقوم الساعة(١) . فتدبّر.
وفي رواية عاصم بن حميد عن الصادق عليه السلام : إنّ لله كرامة في عباده المؤمنين في كلّ يوم جمعة، فإذا كان يوم الجمعة بعث الله إلى المؤمنين ملكا معه حلّة فينتهي إلى باب الجنّة فيقول : استأذنوا لي على فلان، فيقال له : هذا رسول ربّك على الباب، فيقول لأزواجه : أيّ شيء ترينّ عليّ أحسن، فيقلن : يا سيّدنا، والّذي أباحك الجنّة، ما رأينا عليك أحسن من هذا قد بعث إليك ربّك، فيتّزر بواحدة ويتعطّف بالأخرى، فلا يمرّ بشيء إلّا أضاء له حتّى ينتهي إلى الموعد، فإذا اجتمعوا فيه تجلّى لهم الربّ، فإذا نظروا إليه ـ أي إلى رحمته ـ خرّوا سجّدا فيقول : عبادي ارفعوا رؤوسكم، ليس هذا يوم سجود ولا عبادة قد رفعت عنكم المئونة؟
فيقولون : يا ربّ، وأيّ شيء أفضل ممّا أعطيت ؛ أعطيتنا الجنّة؟ فيقول : لكم مثل ما في أيديكم بسبعين ضعفا، فيرجع المؤمن في كلّ جمعة بسبعين
__________________
(١) بحار الأنوار ٨٦ : ٢٨٠.
ضعفا مثل ما في يديه، وهو قوله تعالى :( وَلَدَيْنا مَزِيدٌ ) (١) وهو يوم الجمعة(٢) إلى آخره.
وفضائل هذا اليوم أكثر من أن تحصى كما لا يخفى على من له تتبّع في أخبار أئمّة الهدى، وآداب هذا اليوم أيضا كثيرة فصّلناها في بعض رسائلنا، وكيفيّة «صلاة الجمعة» مشروحة في كتب الفقه.
وفي «الكشّاف» قيل : إنّ الأنصار قالوا : لليهود يوم يجتمعون فيه كلّ سبعة أيّام، وللنصارى مثل ذلك، فهلمّوا نجعل لنا يوما نجتمع فيه فنذكر الله فيه فنصلّي، فقالوا : يوم السبت لليهود، [ويوم الأحد للنصارى](٣) ، فاجعلوه «يوم العروبة» فاجتمعوا الى سعد بن زرارة فصلّى بهم يومئذ ركعتين وذكّرهم فسمّوه يوم الجمعة لاجتماعهم فيه، فأنزل الله «آية الجمعة» فهي أوّل جمعة كانت في الإسلام، وأمّا أوّل جمعة جمعها رسول الله صلّى الله عليه وآله فهي أنّه لمـــّـا قدم المدينة مهاجرا نزل «قباء» على بني عمرو بن عوف وأقام بها يوم الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وأسّس مسجدهم، ثمّ خرج يوم الجمعة عامدا المدينة فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن واد لهم، فخطب وصلّى الجمعة(٤) . انتهى.
وفي «مجمع البيان» : فسمّوه يوم الجمعة حين اجتمعوا إليه، فذبح لهم سعد بن زرارة شاة فتغدّوا وتعشّوا من شاة واحدة وذلك لقلّتهم، فأنزل الله
__________________
(١) ق : ٣٥.
(٢) بحار الأنوار ٨ : ١٢٦.
(٣) أضفناه من المصدر.
(٤) الكشّاف ٤ : ٥٣٢.
في ذلك( إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ ) (١) إلى آخره. انتهى.
و «من» في( مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ) بيانيّة لقوله( إِذا نُودِيَ ) .
قوله :( فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ ) قيل : معنى فاسعوا فامضوا كما في قراءة جماعة من الصحابة كابني عبّاس ومسعود، وفي «الكشّاف» : إنّ عمر سمع رجلا يقرأ : فاسعوا، فقال : من أقرأك ذلك؟ قال : أبيّ بن كعب، فقال : لا يزال يقرأ بالمنسوخ، لو كانت فاسعوا لسعيت حتّى يسقط ردائي(٢) . انتهى.
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم القمّيّ رحمه الله : الإسراع في المشي.
وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر صلّى الله عليه وآله في قوله :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) إلى آخره ؛ يقال : اسعوا أي امضوا، ويقال : اسعوا اعملوا لها، وهو قصّ الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، والغسل، ولبس أفضل ثيابك، وتطيّب للجمعة فهو السعي، يقول الله :( وَمَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَسَعى لَها سَعْيَها وَهُوَ مُؤْمِنٌ ) (٣) (٤) . انتهى.
وقيل : ليس السعي على الأقدام بل على النيّات والقلوب، ولعلّ مراد هذا القائل أنّ المراد بالسعي ليس السعي بالمشي، بل ينبغي له أن يكون من نيّته وعزمه إقامة هذه الصلاة في وقتها، فإنّه مضيّق لا يدرك ثوابها بعد هذا الوقت، ولا يتدارك مصلحتها بالقضاء كسائر الصلوات اليوميّة.
__________________
(١) مجمع البيان، المجلّد ٥ : ٤٣٢.
(٢) الكشّاف ٤ : ٥٣٤.
(٣) الإسراء : ١٩.
(٤) تفسير القمّيّ ٢ : ٣٦٧.
وقيل : المراد الإسراع على وجه القصد والاقتصاد، لا من قبيل العدو، بل دونه.
وقيل : اسعوا أي اعملوا وعجّلوا، فإنّه يوم مضيّق على المسلمين، وروي عن الباقر عليه السلام أيضا.
وفي رواية : إنّ أصحاب النبيّ صلّى الله عليه وآله كانوا يتجهّزون للجمعة أي يتهيّأون لها يوم الخميس، لأنّه يوم مضيّق على المسلمين(١) .
وفي «العلل» بإسناده إلى محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن الصادق عليه السلام قال : إذا قمت إلى الصلاة فأتها سعيا، وليكن عليك السكينة والوقار، فما أدركت فصلّ وما سبقت به فأتمّه، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ ) (٢) إلى آخره.
ومعنى قوله :( فَاسْعَوْا ) هو الانكفاء بالهمزة، أي التمايل إلى قدّام، وفي «مجمع الطريحيّ» : وفي وصفه صلّى الله عليه وآله : كان إذا مشى تكفّى تكفّيا، أي تمايل إلى قدّام، هكذا روي غير مهموز، والأصل الهمز، وبعضهم يرويه مهموزا، وقيل : معناه يتمايل يمينا وشمالا، وخطّأه الأزهريّ بناء على أنّ التكفية الميل إلى سنن ممشاه، كما دلّ عليه قوله فيما بعد «كأنّما ينحطّ من صبب» ولأنّ التمايل يمينا وشمالا من الخيلاء وهو ممّا لا يليق به(٣) . انتهى.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤١٥.
(٢) علل الشرائع ٢ : ٣٥٧.
(٣) مجمع البحرين ٤ : ٥٠ (كفأ).
والصبب : ما انحدر من الأرض، وفي بعض نسخ «العلل» الانكفات بـ «التاء» والظاهر أنّه سهو، فإنّ معناه الانضمام ولا مناسبة له في المقام، فليتأمّل.
والمراد من( ذِكْرِ اللهِ ) هو خصوص «الصلاة» بقرينة قوله :( نُودِيَ لِلصَّلاةِ ) وقوله فيما بعد :( فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ ) لكونها من أفراد «الذكر» لقوله :( أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) (١) ولا ينافي ذلك قوله تعالى :( إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ ) (٢) فإنّ المراد بـ «الصلاة» نفس الأركان المخصوصة المشتملة على الذكر اللفظيّ، وب «الذكر» الذكر القلبيّ، أو المراد بـ «الصلاة» هو عليّ بن أبي طالب عليه السلام، وب «الذكر» محمّد صلّى الله عليه وآله ؛ كما ورد في بعض الروايات. فتأمّل.
وقد يقال : إنّ السعي إلى ذكر الله مقام المريدين، فإنّهم يسعون إلى الذكر سعي مشتاق إلى مذكور يطلب منه محلّ القربة إليه، والدنوّ منه.
قوله :( وَذَرُوا الْبَيْعَ ) أي اتركوه، ولا ماضي لهذا الأمر كما في مرادفه «دع»، وهذا وإن كان على صيغة الأمر إلّا أنّه نهي في حقيقة الأمر، أي لا تبيعوا، والمراد بـ «البيع» مطلق المعاملات المعاوضيّة، فإنّها منافية «لذكر الله» وكاشفة عن إيثار الدنيا على الآخرة.
وقد روي أنّه كان في المدينة إذا أذّن المؤذّن يوم الجمعة، نادى مناد : حرّم البيع حرّم البيع، قال الطبرسيّ رحمه الله : قال الحسن كلّ بيع تفوت فيه الصلاة يوم الجمعة فإنّه بيع حرام لا يجوز، وهذا هو الّذي يقتضيه ظاهر
__________________
(١) طه : ١٤.
(٢) العنكبوت : ٤٥.
الآية، لأنّ النهي يدلّ على فساد المنهيّ عنه(١) . انتهى.
وفيه : إنّ هذا مسلّم في العبادات دون المعاملات كما حقّق في الأصول، نعم سلّمنا دلالة النهي أي صيغته على التحريم كما عليه كثير من المحقّقين، والإجماع ثابت على حرمة البيع بعد النداء، ولكن في فساده بأن لا يحصل معه النقل والانتقال خلاف.
قال العلّامة رحمه الله في «التذكرة» : البيع بعد النداء يوم الجمعة حرام بالنصّ والإجماع، قال الله تعالى :( وَذَرُوا الْبَيْعَ ) والأمر للوجوب، والنهي للتحريم، ولا خلاف بين العلماء في تحريمه، والنداء الّذي يتعلّق به التحريم، هو النداء الّذي يقع بعد الزوال والخطيب جالس على المنبر ـ إلى أن قال ـ :
وهل ينعقد البيع؟ لعلمائنا قولان :
المنع. وبه قال مالك، وأحمد، وداود، لأنّ النهي يقتضي الفساد.
والصحّة. وبه قال الشافعيّ، وأبو حنيفة، لأنّ النهي [في المعاملات] لا يقتضي الفساد، بل في العبادات، ولأنّ البيع غير مقصود في النهي، فإنّه لو ترك الصلاة بالمبايعة كان عاصيا، وإذا كان مقصودا فالتحريم لا يمنع انعقاده، كما لو ترك الصلاة المفروضة بعد ضيق الوقت واشتغل بالبيع، فإنّه يصحّ إجماعا(٢) . انتهى.
قوله :( ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ) إلخ ؛ «ذا» للإشارة إلى ما تقدّم من حضور
__________________
(١) مجمع البيان، المجلّد ٥ : ٤٣٤.
(٢) تذكرة الفقهاء ٤ : ١٠٧ ـ ١١٠.
الجمعة والسعي إلى «ذكر الله» وأداء الفريضة وترك البيع، وكلمة «كم» حرف خطاب إلى المكلّفين، والكلمتان قد تتّفقان وقد تختلفان في الوحدة والتعدّد والتذكير والتأنيث، فيكون المشار إليه واحدا، والمخاطب متعدّدا، وبالعكس، إلى غير ذلك من الصور، ويعرف هذا بباب المخاطبة، وأمّا أنّ ذلك خير، فلأنّ منافع الآخرة أهمّ في نظر العقلاء من منافع الدنيا، لأنّ ما يتعلّق بالآخرة باق دائم، بخلاف ما يتعلّق بالدنيا، ولذا قال الله :( ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ ) (١) إلى آخره.
وفي بعض خطب عليّ عليه السلام : أيّها الناس، انظروا إلى الدنيا نظر الزاهدين فيها، الصادفين عنها، فإنّها والله عمّا قليل تزيل الثاوي الساكن، وتفجع المترقّب الآمن، لا يرجع ما تولّى منها فأدبر، ولا يدني ما هو آت منها فينتظر، سرورها مشوب بالحزن، وجلد الرجال فيها إلى الضعف والوهن، فلا يغرّنّكم كثرة ما يعجبكم فيها لقلّة ما يصحبكم منها، رحم الله امرأ تفكّر فاعتبر، واعتبر فأبصر، وكأنّ ما هو كائن في الدنيا لم يكن، وكأنّ ما هو كائن من الآخرة عمّا قليل لم يزل، فكلّ معدود منقض، وكلّ متوقّع آت، وكلّ آت قريب دان(٢) . انتهى.
قوله :( إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) لا يقال : إنّ ما هو في نفس الأمر خير نافع فهو خير مطلقا سواء علم به أو لم يعلم، فإنّ العلم والجهل لا يؤثّران في حقيقة الشيء وخاصيّته، فما معنى التعليق الّذي مفهومه عدم كونه خيرا مع الجهل؟
__________________
(١) النحل : ٩٦.
(٢) إرشاد القلوب ١ : ٣٤، نهج البلاغة : ١٤٨.
لأنّا نقول : قد أجيب عن ذلك بوجوه :
منها : إنّ المعطوف في المقام محذوف بقرينة المعطوف عليه، والتقدير «إن كنتم تعلمون وإن كنتم لا تعلمون» كما في قوله :( سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ ) (١) أي والبرد، وقد قيل بهذا الوجه في قوله :( فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى ) (٢) أي وإن لم تنفع الذكرى.
ومنها : إنّ لزوم حمل كلام الحكيم على ما لا يلزم اللغو حملنا على القول بالمفهوم، وأمّا إذا كان للتعليق فائدة اخرى فلا يجب القول به، والمقام من هذا القبيل، فإنّ الغرض ذمّ من لا يأتمر بهذا الأمر مع علمه به واستبعاده عن درجة العلم، وتنزيله منزلة الجاهل في عدم العمل به، وقد قيل بذلك أيضا في الآية المذكورة، وأنّه من قبيل قولهم : عظ الظالمين إن سمعوا منك.
ومنها : ما حكي عن الجبّائيّ من أنّ المراد اعلموا ذلك، فتأمّل.
ومنها : إنّ المراد إن كنتم تعلمون أنّه خير لكم اخترتموه على المنافع الدنيويّة.
ومنها : إنّ المراد إن كنتم من أهل العلم والمعرفة بولاية عليّ عليه السلام والأئمّة من ولده، فإنّ شيعتهم هم العلماء حقّا.
فحاصل المفهوم : أنّ أداء هذه الفريضة وأشباهها من سائر العبادات لا يكون خيرا لمن جهل ولايتهم، وهاجر محبّتهم، وقد وردت بذلك أخبار متواترة، بل في بعضها أنّه سواء على الناصب صلّى أم زنى.
__________________
(١) النحل : ٨١.
(٢) الأعلى : ٩.
ومنها : إنّ المراد إن كنتم تعتقدون بحقّيّة هذا الدين، ولا تكونون من المنافقين.
والمراد بـ «القضاء» في قوله سبحانه :( فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) إتمام الشيء وإكماله وفعله على ما ينبغي، وإلى هذا يرجع ما فسّر( قُضِيَتِ ) بأدّيت.
قال أبو البقاء : فكلّما أحكم عمله وختم وأدّى وأوجب وأعلم وأنفذ فقد قضى وفصل.
قال الحلبيّ : القضاء موضوع للقدر المشترك بين هذه المفاهيم، وهو انقطاع الشيء والنهاية، وأصل القضاء الفصل بتمام الأمر. انتهى.
وكيف كان فالمراد بـ «القضاء» في الآية مطلق الفعل والفراغ منه، كما في قوله :( فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ ) (١) أي فرغتم منها، وقوله :( كَلَّا لمـــّـا يَقْضِ ما أَمَرَهُ ) (٢) أي لم يفعل، و «القضاء» في عرف المتشرّعة عبارة عن فعل العبادة المؤقّتة بعد خروج وقتها، ومقابله الأداء، وهو فعلها قبل الخروج.
والمراد بـ «الصلاة» هي صلاة الجمعة، وأوّل وقتها زوال الشمس من يوم الجمعة، وآخر وقتها إذا صار ظلّ [كلّ] شيء مثله، فلا تجوز بعده، بل تتعيّن الظهر.
وعن بعض : إنّ آخر وقتها إذا صار ظلّ الشيء مثليه.
وعن الحلبيّ : إذا مضى مقدار الأذان والخطبة والركعتان فقد فاتت.
__________________
(١) البقرة : ٢٠٠.
(٢) عبس : ٢٣.
والأمر بـ «الانتشار» للإباحة أو الاستحباب، وقد روي عن الصادق عليه السلام أنّه قال : إنّي لأركب في الحاجة الّتي كفاها الله ما أركب فيها إلّا لالتماس أن يراني الله أضحّي في طلب الحلال، أما تسمع قول الله عزّ وجلّ :( فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا ) (١) إلى آخره.
وفي «حقائق القرآن» : إذا فرغتم من مشقّة العبوديّة فانتشروا في الأرض إلى طلب أوليائي، وجالسوهم لتستفيدوا من لقائهم وكلامهم الفوائد الغيبيّة، والأنباء الملكوتيّة، وجالسوا في مجلس السماع والقول فهناك فضل الله من الخطاب، وكشف النقاب. انتهى.
وفي رواية أنس عن النبي صلّى الله عليه وآله :( وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ ) ليس بطلب دنيا ولكن عيادة مريض، وحضور جماعة، وزيارة أخ في الله(٢) .
وعن ابن عبّاس : لم يؤمروا بطلب شيء من الدنيا، إنّما هو عيادة المرضى، وحضور الجنائز، وزيارة أخ في الله.
وعن سعيد بن المسيّب : إنّه طلب العلم.
وعن بعضهم : إنّه صلاة التطوّع.
وفي «التفسير الصادقيّ عليه السلام» : إنّ الانتشار يوم السبت(٣) . وكذا في «تفسير القمّيّ رحمه الله»(٤) .
والمراد بـ «الذكر» أن لا ينسى العبد مولاه في مجامع أحواله سواء كان
__________________
(١) عدّة الداعي : ٩١، مجمع البيان، المجلّد ٥ : ٤٣٥.
(٢) مجمع البيان، المجلّد ٥ : ٤٣٥.
(٣) الفقيه ١ : ٤٢٤.
(٤) تفسير القمّي ٢ : ٣٦٧.
في الصلاة أو في غيرها، وفي «الحقائق» بعد هذه الآية : «أي إذا فرغتم من جميع ذلك غيّبوا بأرواحكم وقلوبكم وعقولكم في بحار الأوّليّة والآخريّة، واذكروا الله بالله لا بكم، واتركوا الذكر هناك بعد رؤية المذكور. انتهى.
وعن بعضهم : أنّ المراد «بالذكر» هو الفكر، فإنّ تفكّر ساعة خير من عبادة سنة أو سبعين سنة، وقد فسّر «الذكر الكثير» في قوله تعالى في سورة الأحزاب :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْراً كَثِيراً ) (١) بما يغلب الأوقات ويعمّ أنواع ما هو أهله من التقديس والتمجيد، والتهليل والتحميد.
وفي بعض الروايات : إنّ تسبيح فاطمة عليها السلام من الذكر الكثير.
وفي بعضها عن الصادق عليه السلام : ما من شيء إلّا وله حدّ ينتهى إليه إلّا الذكر فليس له حدّ ينتهي إليه، فرض الله الفرائض فمن أدّاهنّ فهو حدّهنّ، وشهر رمضان فمن صامه فهو حدّه، والحجّ فمن حجّ فهو حدّه، إلّا الذكر، فإنّ الله لم يرض منه بالقليل، ولم يجعل له حدّا ينتهي إليه، ثمّ تلا هذه الآية(٢) .
وفي بعضها عنه عليه السلام : شيعتنا الّذين إذا خلوا ذكروا الله كثيرا(٣) .
قوله :( لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) : أي لأنّكم تنالوا مقام الفوز بالسعادات الدنيويّة والاخرويّة بسبب هذه الأمور المذكورة في الآية، أو افعلوا ذلك على رجاء منكم في الوصول إلى الفلاح والنجاح، و «الفلاح» هو الفوز بالأماني، والظفر
__________________
(١) الأحزاب : ٤١.
(٢) الكافي ٢ : ٤٩٨.
(٣) الكافي ٢ : ٤٩٩.
بالمطلوب في الخلاص من العذاب، والبقاء على دوام الرحمة.
قيل : الفلح ضربان : دنيويّ وأخرويّ.
والأوّل : الظفر بما تطيب به الحياة الدنيا.
والثاني : ما يفوز به الرجل في دار الآخرة.
وكيف كان فلا يطلق المفلح إلّا على من عقل وحزم وتكاملت فيه خلال الخير، ولذا قال( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ) (١) إلى آخره.
وقال في وصف المتّقين :( وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) (٢) قيل : أي من مكائد النفس والشيطان، وأيضا : مفلحون من الله بالله.
وقيل : أولئك الّذين لزموا طريق المواصلة بالانفصال عمّا سوى الحقّ، فأفلحوا فانقطع الحجب عن قلوبهم فشاهدوا.
وفي قولهم في الأذان والإقامة «حيّ على الفلاح» إشارة إلى أنّ الصلاة عمدة ما يصل بها العبد إلى هذا المقام الشريف، ولذا ورد : أنّ الصلاة عمود الدين ومعراج المؤمنين.
والوجه في تقديم «التجارة» على «اللهو» أوّلا، والعكس ثانيا في قوله سبحانه :( وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَتَرَكُوكَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللهْوِ وَمِنَ التِّجارَةِ وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ) أنّ التجارة كانت مهتمّا بشأنها عند العقلاء، وكان المقام مقام الذمّ والتشنيع على المعرضين عن الصلاة لأمر دنيويّ ناسب الترقّي من الأعلى إلى الأدنى، لأنّهم لعدم رسوخ الإيمان في
__________________
(١) المؤمنون : ١.
(٢) البقرة : ٥، والتوبة : ٨٨، والنور : ٥١.
قلوبهم مائلون إلى النفع الدنيويّ، فإن حصل الكثير منه رجّحوه على القليل منه، وإن لم يحصل الكثير الّذي يهتمّ به العقلاء اكتفوا بالقليل منه حتّى بما لا يترتّب عليه نفع عقلائيّ، ومع ذلك يرجّحونه على الصلاة الّتي هي عمود الدين، وفي هذا كمال التشنيع عليهم، ونظير ذلك أنّك لو أردت التشنيع على بخيل تقول : فلان لا يعطي دينارا ولا درهما، تعني أنّه لا يعطي الكثير، بل لا يعطي القليل.
وأمّا وجه تأخير «التجارة» عن «اللهو» أخيرا، فلأنّ المقام مقام الترقّي من الأدنى إلى الأعلى، فإنّه سبحانه في مقام بيان أنّ الثواب الجزيل الأخرويّ راجح على اللهو الّذي لا نفع فيه ولا اهتمام بشأنه عند العقلاء، بل راجح على التجارة الّتي هي محلّ اعتناء العقلاء، فإنّ النفع المترتّب عليها فان زائل عن قريب، بخلاف الثواب الدائم الّذي لا يفنى ولا يبيد.
قال عليه السلام :
فإن تكن الدنيا تعدّ نفيسة |
فدار ثواب الله أعلى وأنبل |
وقال أيضا :
هب الدنيا تساق إليك عفوا |
أليس مصير ذاك إلى زوال |
|
وما ترجو لشيء ليس يبقى |
وشيكا قد تغيّره اللّيالي |
وكيف كان ففي «الحقائق» بعد ذكر هذه الآية : أخبر الله سبحانه وتعالى أنّهم في أوائل إرادتهم إذا لم يبلغوا إلى حدّ الاستقامة في الصحبة شغلتهم حوائج النفوس عن صحبة النبيّ صلّى الله عليه وآله فعاتبهم الله بذلك، وأمره صلّى الله عليه وآله أن يخبرهم أنّ ما عند الله من مشاهدته صلّى الله عليه وآله
ولقائه، ولذّة خطابه ومناجاته خير من جميع الحظوظ، بقوله :( قُلْ ما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللهْوِ وَمِنَ التِّجارَةِ ) ، وفيه تأديب المريدين حين اشتغلوا عن صحبة المشايخ بخلواتهم وعباداتهم لطلب الكرامات، ولم يعلموا أنّ ما يجدون في خلواتهم بالإضافة إلى ما يجدون في صحبة مشايخهم قليل.
قال سهل : من شغله عن ربّه شيء من الدنيا والآخرة فقد أخبر عن خسّة نفسه، ورذالة همّته، لأنّ الله فتح له الطريق إليه، وأذن له في مناجاته، فاشتغل بما يفنى عمّا لم يزل ولا يزال، قال سهل في قوله( ما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ ) : ما أخّر لكم في الآخرة خير ممّا أعطاكم في الدنيا.
قال الأستاذ : ما عند الله للعباد والزهّاد غدا خير ممّا نالوه من الدنيا نقدا، وما عند الله للعارفين نقدا من واردات القلوب وبوادي الحقيقة خير ممّا يوصل في المستأنف. انتهى.
قوله :( وَإِذا رَأَوْا ) إلى آخره، أي إذا شاهدوا وعاينوا ؛ من الرّؤية بالعين. ولذا عدّي إلى مفعول واحد كما في قولك : «زيدا إذا أبصرته»، وقد يفسّر بإذا علموا، وفيه نظر، لأنّه يتعدّى إلى إثنين ؛ فتدّبر.
و «التجارة» بالكسر : طلب الربح بالبيع والشراء ونحوهما من العناوين المعروفة.
و «اللهو» ما يشغلك عن ذكر الله من الأباطيل والملاهي، أو ما لا يترتّب عليه نفع دنيويّ عقلائيّ، وإن ترتّب عليه نفع خياليّ وهميّ.
قوله :( انْفَضُّوا إِلَيْها ) أي انصرفوا إلى جانبها ومحلّها، وفي «المجمع» :
أي تفرّقوا عنك خارجين إليها، وقيل : مالوا إليها(١) . انتهى.
وبكلّ ذلك فسّر قوله :( وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ) (٢) والضمير المجرور راجع إلى «التجارة».
وعن ابن مسعود : أنّه قرأ «إليهما» بالتثنية.
وعلى الآية على القراءة المشهورة سؤال عن وجه اختصاص «التجارة» بردّ الضمير إليها، وأجاب عنه الطبرسيّ رحمه الله بقوله : لأنّها كانت أهمّ إليهم، وهم بها أسرّ من الطبل، لأنّ الطبل إنّما دلّ على التجارة. عن الفرّاء.
وقيل : عاد الضمير إلى أحدهما اكتفاء به، وكأنّه على حذف، والمعنى : وإذا رأوا تجارة انفضّوا إليها، وإذا رأوا لهوا انفضّوا إليه، فحذف «إليه» لأنّ «إليها» يدلّ عليه(٣) . انتهى.
قال المحقّق النراقيّ رحمه الله في «المشكلات» : ونظير هذه الآية قوله تعالى :( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ ) (٤) فإنّ المذكور شيئان هما «الذهب» و «الفضّة» وأعيد الضمير إلى واحد منهما، والحقّ أنّه عائد إلى الفضّة، لمكان «التاء» لأنّها أقرب، أو لأنّها أكثر وجودا في أيدي الناس، ويمكن أنّ يقال : إنّ الضمير عائد إلى المكنوز وهو يعمّ الدراهم والدنانير وسائر الأموال.
ثمّ النكتة في إعادة الضمير في الآية إلى «التجارة» دون «اللهو» مع أنّها
__________________
(١) مجمع البيان، المجلّد ٥ : ٤٣٦.
(٢) آل عمران : ١٥٩.
(٣) مجمع البيان، المجلّد ٥ : ٤٣٦.
(٤) التوبة : ٣٤.
أبعد، ومؤنّث أيضا هي أنّ التجارة أجذب لقلوب العباد عن طاعة الله [من اللهو] بدليل أنّ المشتغلين بها أكثر من المشتغلين باللهو، ولأنّها أكثر نفعا من اللهو، ولأنّها كانت أصلا واللهو تبعا، لأنّهم كانوا يضربون بالطبل عند قدومها(١) . انتهى.
والحاصل : أنّ اهتمامهم بالتجارة كان أكثر من اهتمامهم باللهو، ولذا خصّت بردّ الضمير إليها، بل في ذلك إيماء إلى أنّ اللهو ليس ممّا يعتدّ به، ويعتني بذكره، بل المقصود الأصليّ هو التجارة.
وكيف كان ففي «تفسير عليّ بن إبراهيم القمّيّ رحمه الله» قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يصلّي بالناس يوم الجمعة ودخلت ميرة وبين يديها قوم يضربون بالدفوف والملاهي، فترك الناس الصلاة ومرّوا ينظرون إليهم، فأنزل الله قوله :( وَإِذا رَأَوْا ) (٢) إلى آخره.
والميرة بكسر «الميم» وسكون «الياء» : طعام يمتاره الإنسان، أي : يجلبه من بلد إلى بلد، يقال : مار القوم : إذا أتاهم بالطعام. ومنه قوله تعالى :( وَنَمِيرُ أَهْلَنا ) (٣) .
وفي الحديث : سمّي أمير المؤمنين عليه السلام لأنّه يميرهم العلم(٤) .
والمراد أنّ هذا الاسم كان في الأصل حكاية عن قوله عليه السلام :
__________________
(١) مشكلات العلوم : ٢٥٣ ـ ٢٥٤.
(٢) تفسير القمّيّ ٢ : ٣٦٧.
(٣) يوسف : ٦٥.
(٤) الكافي ١ : ٤١٢.
أمير المؤمنين، أي أنا أطعمهم بالعلم. فـ «أمير» صيغة متكلّم من «مار، يمير» كباع يبيع.
وفي «الكشّاف» : روي أنّ أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء شديد، فقدم دحية بن خليفة بتجارة من زيت الشام والنبيّ صلّى الله عليه وآله يخطب يوم الجمعة، فقاموا إليه، خشوا أن يسبقوا إليه، فما بقي معه إلّا يسير ـ قيل : ثمانية، وأحد عشر، وإثنا عشر، وأربعون ـ فقال عليه السلام : والّذي نفس محمّد بيده! لو خرجوا جميعا لأضرم الله عليهم الوادي نارا، وكانوا إذا أقبلت العير استقبلوها بالطبل والتصفيق، فهو المراد بـ «اللهو»(١) .
وعن قتادة : فعلوا ذلك ثلاث مرّات في كلّ مقدم عير(٢) . انتهى.
وفي رواية جابر بن عبد الله : أقبلت عير ونحن نصلّي مع رسول الله فانفضّ الناس إليها فما بقي غير اثني عشر رجلا أنا فيهم، فنزلت الآية(٣) .
وفي «تفسير البيضاويّ» : والترديد أي بين اللهو والتجارة بكلمة «أو» للدلالة على أنّ منهم من انفضّ بمجرّد سماع الطبل ورؤيته(٤) . انتهى.
قوله «قائما» أي على المنبر حال الخطبة والوعظ، ويستفاد منه وجوب القيام في هذه الخطبة واشتراطه فيها، قال العلّامة في التذكرة : الثالث ـ أي من شروط الخطبة ـ : قيام الخطيب حال خطبته عند علمائنا أجمع. وبه قال الشافعيّ، لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله خطب قائما، فيجب متابعته، ولقول
__________________
(١ و ٢) الكشّاف ٤ : ٥٣٦ ـ ٥٣٧.
(٣) بحار الأنوار ٢٢ : ٥٩.
(٤) أنوار التنزيل وأسرار التأويل ٢ : ٤٩٣.
الصادق عليه السلام : أوّل من خطب وهو جالس معاوية ؛ استأذن الناس في ذلك لوجع كان بركبتيه. إلى أن قال : لو خطب جالسا مع القدرة بطلت صلاته لفوات شرط الخطبة(١) . انتهى.
والواجب فيها خطبتان وادّعى على ذلك العلّامة رحمه الله الإجماع، قال : ولأنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله كان يخطب خطبتين، ولأنهما أقيما مقام ركعتين، فالإخلال بإحداهما منهما إخلال بركعة(٢) . انتهى.
ويستفاد أيضا من الآية حرمة انفضاض من حضر في المسجد وتفرّقهم قبل إتمامهم الصلاة واستماعهم للخطبة، لأنّ الله تعالى ذمّهم على هذا العمل.
وفروع صلاة الجمعة كثيرة، إلّا أنّ اشتراطنا في مشروعيّتها حضور الإمام المعصوم عليه السلام قد كفانا تجشّم مؤنة بيان هذه الفروع، وعلى من لا يشترطه، الرجوع إلى كتب الفقه.
والدليل على قوله تعالى( وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ) أنّ كلّ رزق ينتفع به العبد ولو من غير الله فأصله من الله، وإنّما الغير واسطة لوصوله إلى العبد، والرزق مقسوم من عنده تعالى لا يزيده قيام حريص، ولا ينقصه قعود مخمل، وقد قال الله تعالى :( نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ ) (٣) .
وفي مواعظ النبيّ صلّى الله عليه وآله في حجّة الوداع : ألا وإنّ الروح
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٤ : ٧٠.
(٢) تذكرة الفقهاء ٤ : ٦٢.
(٣) الزخرف : ٣٢.
الأمين نفث في روعي أنّه لا تموت نفس حتّى تستكمل رزقها، فأجملوا في الطلب، ولا يحملنّكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، [فإنّ الله] قسّم الأرزاق بين خلقه حلالا ولم يقسّمها حراما، فمن اتّقى وصبر أتاه رزق الله، ومن هتك حجاب الستر وعجّل فأخذه من غير حلّه قرصص به من رزقه الحلال، وحوسب به يوم القيامة(١) . انتهى.
وهذا ممّا يدلّ على صحّة تفسير المعتزلة للرزق بأنّه كلّ ما صحّ انتفاع الحيوان به بالتغذّي أو غيره، وليس لأحد منعه منه، وعلى بطلان قول الأشاعرة بأنّه كلّ ما انتفع به وإن كان حراما، فالحقّ أنّ الرزق المقسوم لا يكون إلّا حلالا.
نعم في حديث عمر بن قرّة : أي عدوّ الله، لقد رزقك الله طيّبا فاخترت ما حرّم الله عليك من رزقه مكان ما أحلّ الله لك من حلاله(٢) إلى آخره. فتأمّل.
خاتمة : قال الكفعميّ رحمه الله في «مصباحه» : من أدمن قراءتها أي سورة الجمعة ـ ليلا ونهارا، صباحا ومساء أمن من وسوسة الشيطان(٣) . انتهى.
وروى مرسلا عن النبيّ صلّى الله عليه وآله أنّه قال : من قرأها أعطي عشر حسنات بعدد من أتى الجمعة، ومن يأتيها في أمصار المسلمين(٤) .
__________________
(١) عدّة الداعي : ٨٣.
(٢) بحار الأنوار ٥ : ١٥٠.
(٣) مصباح الكفعميّ : ٤٥٧.
(٤) مصباح الكفعميّ : ٤٤٧.
قال رحمه الله : وعن الصادق عليه السلام : من الواجب على كلّ مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة والأعلى وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين، فإذا فعل ذلك فكأنما يعمل بعمل النبيّ صلّى الله عليه وآله وكان ثوابه وجزاؤه على الله الجنّة(١) . انتهى.
ورواه أيضا الصدوق رحمه الله في «ثواب الأعمال»(٢) والطبرسيّ رحمه الله في «مجمع البيان»(٣) .
تمّ الكتاب بيد مصنّفه
__________________
(١) مصباح الكفعميّ : ٤٤٧.
(٢) ثواب الأعمال : ١١٨.
(٣) مجمع البيان، المجلّد ٥ : ٤٢٧.
تفسير
سورة الملك
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[المقدّمة]
حامدا مسبّحا لمن بيده الملك وهو على كلّ شيء قدير، ومصلّيا على رسوله البشير النذير، وعلى آله العارفين بموارد التأويل ومصادر التفسير.
أمّا بعد، فيقول العبد الضعيف ابن علي مدد حبيب الله الشريف : إنّ هذه العجالة(١) تفسير موجز لسورة «الملك» الّتي من قرأها تنجيه وتقيه من عذاب القبر ؛ فلذا سمّيت «بالمنجية» و «الواقية» أيضا.
وقد روي عن النبي صلّى الله عليه وآله أنّه قال : إنّ سورة من كتاب الله ما هي إلّا ثلاثون آية، شفعت لرجل، فأخرجته يوم القيامة من النار، وأدخلته الجنّة، وهي سورة تبارك(٢) .
وهذا الحديث يعضد ما عليه أكثر القرّاء من أنّ آياتها ثلاثون، ويردّ ما ذهب إليه إسماعيل المكّيّ والمدنيّ الأخير(٣) ـ وهو إسماعيل بن جعفر من قرّاء المدينة ـ من أنّ عدد هذه السورة بحسب الآيات إحدى وثلاثون، فزعم
__________________
(١) العجالة : ما تعجّلته من كلّ شيء، ما حضر من الطعام، ما يعجّل للضيف منه. المنجد في اللغة.
(٢) مجمع البيان ١٠ : ٤٠٦.
(٣) والمدنيّ الأوّل : يزيد بن القعقاع.
أنّ قوله تعالى :( قَدْ جاءَنا نَذِيرٌ ) (١) آية مستقلّة لاجزء الآية ؛ أي قوله :( كُلَّما أُلْقِيَ فِيها فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ * قالُوا بَلى قَدْ جاءَنا ) (٢) إلى آخره.
قال الطبرسيّ رحمه الله في أوائل مجمع البيان : والفائدة في معرفة ؛ آي القرآن أنّ القارئ إذا عدّها بأصابعه كان أكثر ثوابا، لأنّه قد شغل يده بالقرآن مع قلبه ولسانه، وبالحريّ أن تشهد له يوم القيامة، فإنّها مسؤولة، ولأنّ ذلك أقرب إلى التحفّظ، فإنّ القارئ لا يأمن السهو(٣) . انتهى.
وليعلم أنّ لفظ «السورة» يهمز ولا يهمز ؛ كما هو المشهور.
قال الحسن بن محمّد القمّيّ النيسابوريّ في تفسيره المسمّى بغرائب القرآن : وعليه ـ أي على ترك الهمز ـ القراءة، قال : والسورة اسم لآي جمعت وقرنت بعضها إلى بعض حتّى تمّت وكملت وبلغت في الطول المقدار الّذي أراد الله تعالى، ثمّ فصل بينها وبين سورة أخرى ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا تكون السورة إلّا معروف المبتدأ، ومعلوم المنتهى.
وقيل : اشتقاقها من سور البناء والمدينة، لأنّ السور يوضع بعضه فوق بعض حتّى ينتهي إلى الارتفاع الّذي يراد، فالقرآن أيضا وضع آية إلى جنب آية حتّى بلغت السورة في عدد الآي المبلغ الّذي أراد الله تعالى.
وقيل : سمّيت سورة، لأنّها وصفت بالعلوّ والرفعة ؛ كما أنّ سور المدينة سمّي سورا لارتفاعه. قال النابغة :
__________________
(١) الملك : ٩.
(٢) الملك : ٨.
(٣) مجمع البيان ١ : ٩.
ألم تر أنّ الله أعطاك سورة |
ترى كلّ ملك دونها يتذبذب |
أي شرفا ورفعة.
وقيل : سمّيت سورة لإحاطتها بما فيها من الآيات ؛ كما أنّ سور المدينة محيط بمساكنها وأبنيتها.
وجمع سورة القرآن «سور» بفتح الواو ؛ مثل جملة وجمل، وجمع سور البناء «سور» بالسكون، مثل صوفة وصوف(١) . انتهى.
وإنّما سمّيت «الآية» آية لكونها علامة لصدق النبيّ صلّى الله عليه وآله ولإعجازه، أو عجيبة ممّن أتى بها دالّة على صدقه في دعواه ؛ أنّها من الله كاشفة عن مباينها كلام المخلوق.
وقيل : «الآية» بمعنى الجماعة من الحروف ؛ من قولهم : خرج القوم بآيتهم ؛ أي بجماعتهم بحيث لم يدعوا وراءهم أحدا.
وقد اختلف في وزنها أيضا ؛ فعن الخليل : أنّه «فعلة» محرّكة، فأصلها «آيية» قلبت «الياء» الأولى «ألفا» لتحرّكها وانفتاح ما قبلها. وعن الفرّاء : إنّ أصلها «آيّة» بتشديد «الياء». وعن الكسائيّ : إنّ أصلها «آيية» على وزن «فاعلة» فحذفت إحدى الياءين للاستثقال.
وكيفما كان فربّما يجعل في أسماء هذه السورة تبارك كما في [سورة] «ص» و [سورة] «ق» لافتتاحها بهذه الكلمة. وفيه نظر، فإنّ الغرض من وضع الأعلام : التعيين، واشتراكها مع سورة «الفرقان» المفتتحة بها ينافيه، فتأمّل.
__________________
(١) غرائب القرآن ورغائب الفرقان ١ : ٢٨ ـ ٢٩.
إذا عرفت هذه الجملة فاستمع لما يتلى عليك من تفسير هذه السورة الشريفة،فنقول :
قال الله تبارك وتعالى :( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) وهذا تعليم للعباد، وإرشاد لهم إلى سنن السداد، ليكمل جلائل مقاصدهم، ويتمّ عظائم فوائدهم ؛ أي : قولوا يا عبادي! هذه الكلمات متوسّلين بها إلى نجح الكرامات، وتقدير القول في أمثال المقام ممّا لا بدّ منه ؛ كما لا يخفى.
وفضائل البسملة وأسرارها وخواصّها ممّا لا يعدّ ولا يحصى، بل المؤمن بتركها في مواردها يمحّص ويبتلى ؛ كما يشهد به قصّة عبد الله بن يحيى، فإنّه دخل على أمير المؤمنين عليه السلام وبين يديه كرسيّ فأمره بالجلوس، فجلس عليه، فمال به حتّى سقط على رأسه، فأوضح عن عظم رأسه وسال الدم، فأمر [أمير المؤمنين] عليه السلام بماء، فغسل عنه ذلك الدم، ثمّ قال : ادن منّي، فدنا منه، فوضع يده على موضحته وقد كان يجد [من] ألمها ما لا صبر له معه، ومسح يده عليها وتفل فيها [فما هو أن فعل ذلك] حتّى اندمل وصار كأنّه لم يصبه شيء قطّ.
ثمّ قال عليه السلام : يا عبد الله، الحمد لله الّذي جعل تمحيص ذنوب شيعتنا في الدنيا بمحنتهم، لتسلم لهم طاعتهم، ويستحقّوا عليها ثوابها.
فقال عبد الله [بن يحيى] : يا أمير المؤمنين، [و] إنّا لا نجازى بذنوبنا إلّا في الدنيا؟
قال : نعم، أما سمعت قول رسول الله صلّى الله عليه وآله : الدنيا سجن المؤمن، وجنّة الكافر، إنّ الله يطهّر شيعتنا من ذنوبهم في الدنيا بما يبتليهم
من المحن، وبما يغفره لهم، فإنّ الله يقول :( وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ) (١) حتّى إذا وردوا(٢) القيامة توفّرت عليهم طاعاتهم وعباداتهم، وإنّ أعداء محمّد وأعداءنا يجازيهم على طاعة تكون منهم في الدنيا ـ وإن كان لا وزن لها، لأنّه لا إخلاص معها ـ حتّى إذا وافوا القيامة حملت عليهم ذنوبهم وبغضهم لمحمّد وآله وخيار أصحابه فقذفوا لذلك في النار.
ثمّ ذكر عليه السلام له قصّة الرجل الكافر الّذي اشتهى في مرضه السمكة في غير أوانها، والرجل المؤمن الّذي اشتهاها في أوانها(٣) .
فقال عبد الله : يا أمير المؤمنين، قد أفدتني وعلّمتني، فإن رأيت أن تعرّفني ذنبي الّذي امتحنت به في هذا المجلس ؛ حتّى لا أعود إلى مثله.
قال : تركك حين جلست أن تقول «بسم الله الرّحمن الرّحيم» فجعل الله ذلك لسهوك عمّا ندبت إليه تمحيصا بما أصابك، أما علمت أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله حدّثني عن الله، أنّه قال : كلّ أمر ذي بال لم يذكر اسم الله فيه فهو أبتر؟!
فقلت : بلى بأبي أنت وأمّي، لا أتركها بعدها.
قال : إذا تحظى بذلك وتسعد.
ثمّ قال عبد الله : يا أمير المؤمنين، ما تفسير( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) ؟
قال عليه السلام : إنّ العبد إذا أراد أن يقرأ أو يعمل عملا يقول «بسم الله»
__________________
(١) الشورى : ٣٠.
(٢) في المصدر : أوردوا.
(٣) انظر : بحار الأنوار ٩٢ : ٢٤٠.
أي بهذا الاسم أعمل هذا العمل، فكلّ عمل يعمله يبتدئ(١) فيه بـ «اسم الله» فإنّه يبارك فيه(٢) . انتهى.
ويستفاد من آخر هذا الحديث رجحان تقدير متعلّق الباء الّتي من حروف الجرّ فعلا متأخّرا، وإن احتمل فيه وجوه أربعة :
أحدها : ما ذكر.
وثانيها : تقدير الفعل متقدّما ؛ أي أبدأ بسم الله ؛ كما في قوله :( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ) (٣) .
وثالثها : تقدير الاسم متأخّرا ؛ أي بسم الله ابتدائي ؛ كما في قوله تعالى :( بِسْمِ اللهِ مَجْراها وَمُرْساها ) (٤) .
ورابعها : تقديره متقدّما ؛ أي ابتداء كلامي بسم الله، وقد يستدلّ على أولويّة التقديم بأنّ وجود واجب الوجود لذاته سابق على وجود غيره، والسابق في الذات يستحقّ السبق في الذكر، مع أنّ التقديم في الذكر أدخل في التعظيم. فتأمّل.
وحكي عن الجنيد ؛ أنّه قال : إنّ أهل المعرفة نفوا عن قلوبهم كلّ شيء سوى الله، فقال لهم : قولوا بسم الله ؛ أي تسمّوا بي ودعوا انتسابكم إلى آدم، ولعلّ مراده أنّه لا تفتخروا بانتسابكم إلى آدم عليه السلام وأنّكم أولاده، بل افتخروا بأنّكم عبادي وخلقي.
__________________
(١) في المصدر : كلّ أمر يبدأ.
(٢) تفسير الإمام : ٢٢.
(٣) العلق : ١.
(٤) هود : ٤١.
ويستفاد منه، أنّ الباء متعلّقة بتسمّوا المضمر متأخّرا، والبسملة الّتي في أوائل السور آية مستقلّة وجزء منها ؛ باتّفاق أصحابنا الإماميّة، ومخالفونا مختلفون في ذلك. نعم، البسملة الثانية في سورة النمل جزء من الآية ؛ كما لا يخفى. وكذا في الفاتحة عند من يقف على «العالمين» دون «الرحيم».
والأكثرون على أنّ الاسم مشتقّ من السموّ ؛ وهو العلوّ والرفعة، لأنّ جمعه المكسّر على أسماء، وتصغيره على سميّ، ويدلّ عليه سائر تصاريفه. وذهب الكوفيّون إلى أنّ مبدأ اشتقاقه الوسم، والسمة بمعنى العلامة. وحسبك في ردّهم عدم جمعهم له على أوسام، وعدم تصغيره بوسيم، وكونه علامة للمسمّى ومعرّفا لا يقتضي اشتقاقه من الوسم، مع أنّ السموّ أيضا مناسب له.
قيل : لأنّ التسمية تنويه بالمسمّى، وإشادة بذكره.
وقيل : لأنّ الاسم معرّف، والمعرّف لكونه متقدّما على المعرّف، عال عليه.
ولكن روي عن الرضا عليه السلام أنّه قال في تفسير البسملة ؛ يعني : أسم نفسي بسمة من سمات الله [وهو العبوديّة. قال : فقلت : ما السمة؟ قال : العلامة](١) . فتأمّل.
والحقّ تغاير الاسم والمسمّى والتسمية مفهوما ومصداقا، فإنّ الاسم قد يكون موجودا، والمسمّى معدوما، بل ممتنعا ؛ كشريك الباري، وقد يعكس ؛ كما في الحقائق الّتي لم يوضع لها اسم. وقد يكون الاسم كثيرا
__________________
(١) بحار الأنوار ٩٢ : ٢٣٠.
والمسمّى واحدا ؛ كما في الترادفات، وقد يعكس ؛ كما في الألفاظ المشتركة. وذيل الكلام في هذا المقام طويل، ولكنّه قليل الجدوى.
نعم، لو أريد بالاسم صفة الحقّ تعالى فالحقّ العينيّة ؛ كما فصّل في محلّه، والفرق بين التسمية والاسم أنّ التسمية هي تعيين اللفظ بإزاء المعنى المعيّن، فالاسم هو اللفظ المعيّن، والتسمية هي تعيينه، فالتغاير واضح ؛ كما لا يخفى، وقد بسطنا الكلام في ذلك في تفسير الفاتحة.
وقد يقال : إنّه لا معنى للاستعانة بالاسم، وإنّما هو حرف وصوت، وكلاهما مخلوق، فلا يستعان به، فلا بدّ من القول بزيادة لفظ الاسم ؛ كما في قوله :( تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ) (١) ، وقوله :( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ ) (٢) وقول الشاعر :
إلى الحول ثمّ اسم السلام عليكما(٣)
وفيه نظر من وجوه لا تخفى.
ومن أسمائه الحسنى، كلمة «الله» وهو علم لذاته المستجمع لجميع الصفات الكماليّة، فإن كان الواضع هو الله فلا إشكال، وإلّا فلا يشترط في الوضع الإدراك الكلّيّ التامّ للموضوع له، وممّا يدلّ على كونه اسما للذات وقوعه موصوفا لسائر الأسماء، لا صفة، ومنها «الرحمن» و «الرحيم»، والأوّل اسم خاصّ بصفة عامّة، أمّا الأوّل، فلأنّه لا يطلق على غير الله، وأمّا الثاني، فإنّ هذه الرحمة تشمل المؤمن والكافر. والثاني اسم عامّ بصفة خاصّة، أمّا
__________________
(١) الرحمن : ٧٨.
(٢) الأعلى : ١.
(٣) تكملة البيت : ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر. والبيت للشاعر لبيد.
الأوّل فلإطلاقه على الله وعلى غيره، وأمّا الثاني فلاختصاص هذه الرحمة بالمؤمنين ؛ كما قال :( وَكانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً ) (١) .
وفي البسملة أسرار عجيبة، وخصائص غريبة، وأبحاث كثيرة ؛ قد طوينا الكشح عن شرحها، مخافة الإطالة.
( تَبارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ ) أي تعالى الله وتعاظم في أسمائه وصفاته وأفعاله عن كلّ شيء، فلا لأحد أن يعرفه حقّ معرفته، أو يصفه حقّ صفته، أو كثرت خيراته وتزايدت فيوضاته على كلّ مخلوق بحسب استعداده وقابليّته ؛ كما قال :( فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها ) (٢) من البركة، وهي زيادة الخير وكثرته ونماؤه.
ومنه قوله صلّى الله عليه وآله : بورك لأمّتي في سبتها وخميسها(٣) .
وفي سورة الإسراء :( إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ ) (٤) أي بكثرة النعم من كلّ جنس.
وقوله صلّى الله عليه وآله : تسحّروا، فإنّ في السحور بركة(٥) . أي زيادة القوّة على الصوم، وقيل ؛ أي زيادة في العمر.
أو تقدّس وجلّ بما لم يزل عليه من الصفات، ولا يزال كذلك، فلا
__________________
(١) الأحزاب : ٤٣.
(٢) الرعد : ١٧.
(٣) بحار الأنوار ٥٩ : ٣٦.
(٤) الإسراء : ١.
(٥) بحار الأنوار ٦٢ : ٢٩٢، إلّا أنّه ليس فيه كلمة «في»، وأيضا : طبّ النبيّ : ٢٢، وعوالي اللئالي ١ : ١٠٤.
يشاركه فيها غيره، أو قام بكلّ بركة، وجاء بكلّ بركة، من بروك الطائر على الماء ؛ أي ثبوته ووقوفه عليه، ومنه «البركة» بكسر الباء وسكون الراء للمكان الّذي يثبت فيه الماء، ويعدّ لإقامة الماء فيه، ويقال : برك البعير : إذا ناخ في موضعه فلزمه.
قال أبو البقاء : البركة : النماء والزيادة ؛ حسّيّة كانت أو معنويّة، وثبوت الخير الإلهيّ في الشيء ودوامه، ونسبتها إلى الله تعالى على المعنى الثاني ـ إلى أن قال ـ : وبارك على محمّد صلّى الله عليه وآله : أدم ما أعطيته من الشرف والكرامة انتهى، فتأمّل.
وإلى بعض ما ذكرناه يرجع ما قيل في تفسيره بأنّه تقديس الذات والصفات عن الإدراك، وما قيل في معناه ؛ أي تعالى الله عن الأشباه ؛ إذ لا شبيه له في الأزل، وتقدّس عن الأضداد ؛ إذ لم يكن له ضدّ إلى أبد الأبد.
وفي بعض كلمات الأكابر : تبارك كالكناية، والكناية كالإشارة، والإشارة لا يدركها إلّا الأكابر. وفي بعضها : أي هو المبارك ؛ أي بكسر الهاء على من انقطع إليه وكان له، وهذا الفعل إذا نسب إلى الذات فهو تنزيه له، ولذا نسب إلى الاسم ؛ كما في قوله :( تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ) (١) فهو تنزيه له والمبارك بفتح الراء : النفّاع ؛ كما في قوله :( وَجَعَلَنِي مُبارَكاً ) (٢) ؛ أي نفّاعا كثير الخير. ويقال للسائل : بورك فيك، يقصد به ردّ سؤاله، لا الدعاء له. وبه صرّح أبو البقاء في كلّيّاته.
__________________
(١) الرحمن : ٧٨.
(٢) مريم : ٣١.
والليلة المباركة : ليلة القدر، لنزول القرآن فيها. وقيل : النصف من شعبان.
والشجرة المباركة : شجرة الزيتون، لأنّها كثيرة البركة والمنفعة ؛ يسرج دهنها، ويؤتدم به، ويوقد بحطبها، وهي أوّل شجرة نبتت بعد الطوفان.
والذكر المبارك : القرآن، لما فيه من زيادة البيان على الكتب السماويّة، ولأنّه لا ينسخ فيبقى إلى يوم القيامة، فيكثر الانتفاع به. وفي جعل المسند إليه موصولا تعظيم وإشارة إلى جهل المخاطبين بحقيقة ذاته، وأنّهم يعرفون أنّه تعالى مالك الملك، والمتصرّف فيه بما يشاء، فيؤتيه من يشاء، وينزعه ممّن يشاء ؛ كما قال :( قُلِ أللّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) (١) ، وقوله :( بِيَدِهِ الْمُلْكُ ) ؛ أي في قبضة قدرته الملك، فـ «الباء» بمعنى «في» كما في قوله :( وَالسَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ) (٢) فالتعبير باليد كناية عن كمال القدرة وقوّتها، والأولى حمل الملك على جميع ما سوى الله من العوالم الإمكانيّة دون خصوص عالم الأجسام والطبائع ؛ أي مقابل عالم الملكوت، وهو عالم الأرواح جملة، وقد يطلق على عالم المثال خاصّة، ويقال على الأوّل : الملكوت العامّة، وعلى الثاني : الخاصّة.
وفي بعض العبارات : إنّ الملكوت هو عالم الملائكة خاصّة، وفي بعضها : إنّ ملكوت الشيء حقيقته المجرّدة اللطيفة، الغير المقيّدة بقيود
__________________
(١) آل عمران : ٢٦.
(٢) الزمر : ٦٧.
كثيفة جسمانيّة، ومنه قوله تعالى :( بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ) (١) .
وقد يقال : عالم الملك والملكوت ويراد به عالم الشهادة والغيب، ولعلّ الاكتفاء بالملك في الآية لانطوائه على الملكوت، فالظاهر المحسوس من كلّ شيء هو الملك، وحقيقته الباطنيّة المنطوية فيه هي الملكوت، ولعلّه مراد من قال : كلّ شيء فيه معنى كلّ شيء. فتفطّن واصرف الذهن إليّ. فتأمّل.
وفي الكلّيّات : الملك بالكسر أعمّ من المال، يقال : ملك النكاح، وملك القصاص، وملك المتعة، فهو قدرة يثبتها الشارع ابتداء على التصرّف، فخرج نحو الوكيل، كذا في فتح التقدير. وينبغي أن يقال : إلّا لمانع كالمحجور عليه، فإنّه مالك ولا قدرة له على التصرّف، والمبيع المنقول ملك للمشتري ولا قدرة له على بيعه قبل قبضه، وملك يميني أفصح من الكسر.
والملك بالضمّ : عبارة عن القدرة الحسّيّة العامّة لما يملك شرعا، ولما لا يملك.
وفي القاموس : بالضمّ معلوم، ويؤنّث، وبالفتح ككتف وأمير وصاحب : ذو الملك(٢) .
وقال الزجّاج : بالضمّ : السلطان والقدرة، وبالكسر : ما حوته اليد، وبالفتح : مصدر. وقيل : بالضمّ يعمّ التصرّف في ذوي العقول وغيرهم،
__________________
(١) يس : ٨٣ ؛ المؤمنون : ٨٨.
(٢) القاموس المحيط ٣ : ٤٦٧ (ملك).
وبالكسر يختصّ بغير العقلاء. وقيل : بينهما عموم وخصوص من وجه، فالمضموم هو التسلّط على من يتأتّى منه الطاعة، ويكون بالاستحقاق وغيره، والمكسور كذلك، إلّا أنّه لا يكون إلّا بالاستحقاق. والملك بالفتح وكسر اللّام أدلّ على التعظيم بالنسبة إلى المالك، لأنّ «التصرّف» في العقلاء المأمورين بالأمر والنهي أرفع وأشرف من التصرّف في الأعيان المملوكة الّتي أشرفها العبيد والإماء إلى آخره. انتهى.
ويظهر من بعض العارفين أنّ المراد بالملك في الآية هو ملك مشاهدة الحقّ، قال : وهم ؛ ـ أي المحبّون ـ في ملك قربه لا ينقطع عنهم وصاله أبدا. انتهى.
ويحتمل أن يراد بـ «الملك» النبوّة والرسالة ؛ كما قال :( اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ ) (١) وأن يراد به الولاية العامّة والخاصّة، وكيف كان فالحمل على العموم أولى.
ويظهر ممّا ذكرناه أنّ الملك بالضمّ مبدأ لاشتقاق الملك بالفتح فالكسر، وبالكسر مبدأ لاشتقاق المالك، فترجح قراءة من قرأ في سورة الفاتحة : ملك يوم الدين على قراءة من قرأ :( مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ) ومن قرأ : ملك يوم الدين على صيغة الفعل الماضي، فإنّ الملكيّة مستلزمة للقدرة على التصرّف دون المالكيّة، مع أنّ الأولى تقتضي التصرّف في عظائم الأمور وجلائلها دون الثانية، يقال : فلان مالك الدرهم، ولا يقال : ملك الدرهم، ويقال : فلان ملك الدهر، ولا يقال : مالك الدهر.
__________________
(١) الأنعام : ١٢٤.
وبالجملة : الوصف بالملك أمدح من الوصف بالمالك، وقد فصّلنا هذه الجملة في تفسيرنا على سورة الفاتحة. وفي «الرسالة الواضحة في تفسير سورة الفاتحة» للكفعميّ رحمه الله : إن وصف الله بأنّه ملك كان ذلك من صفات الذات، وإن وصف بأنّه مالك كان من صفات الأفعال، ولعلّ نظره في هذا التفصيل إلى أنّ المالك مستلزم للمملوك والمفروض أنّه لم يكن مع الله شيء في أزل الآزال ؛ بخلاف الملك، فإنّه لم يزل قادرا على التصرّف في جميع الأمور، فكان هذه الملك مطلقا، ولا يزال كذلك أبدا ؛ كما يشير إليه قوله تعالى :( لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ ) (١) فافهم وتأمّل جيّدا!
ثمّ لا يذهب عليك أنّ مملوكيّة الأشياء لمالكيها والممالك لسلاطينها وملوكها من الأمور الاعتباريّة الّتي لا ثبات لها في حدّ أنفسها، وكذا مالكيّة ما سوى الحقّ تعالى وملكيّته، فإنّ تصرّفه في ذلك ليس بالإيجاد والإفناء والإحياء والإماتة متى شاء وأراد.
غاية الأمر : أنّ تصرّفه فيه نظير تصرّف النفوس في الأعضاء والجوارح الّتي هي من آلاتها وأدواتها، فلا قدرة لها بدونها على شيء، فهي محتاجة إليها عند إرادتها شيئا ؛ بخلاف مالكيّة الحقّ تعالى وملكيّته، فإنّ ذلك أمر حقيقيّ، وتصرّفه في الأشياء والمماليك نظير تصوّر النفوس لصورها العلميّة الحاصلة عندها يوجد ما شاء منها، ويفني ما شاء منها، ويفعل فيها ما شاء، ومتى شاء، وكيفما شاء، وإنّما أمره سبحانه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فملكيّته ومالكيّته ثابتة دائمة غير منصرمة أبد الآبدين.
__________________
(١) غافر : ١٦.
فإن قلت : إذا كانت الملكيّة من صفات الذات الّتي هي عين الذات، فكيف قال :( قُلِ أللّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ ) (١) إلى آخره.
قلت : قوله :( تُؤْتِي الْمُلْكَ ) إلى آخره، قرينة على أنّ المراد بهذا الملك غير ما أشرنا إليه ؛ نظير العزّة والذلّة. فليتأمّل.
تتمّة : قال فخر الدين الرازيّ في تفسيره الكبير : إنّه يتفرّع على كونه سبحانه ملكا أحكام :
منها : أنّ السياسات على أربعة أقسام : سياسة الملّاك، وسياسة الملوك، وسياسة الملائكة، وسياسة ملك الملوك.
فسياسة الملوك أقوى من سياسة الملّاك، وسياسة الملائكة فوق سياسة الملوك، وسياسة ملك الملوك فوق سياسة الملائكة، ألا ترى إلى قوله :( يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا لا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَقالَ صَواباً ) (٢) فيا أيّها الملوك، لا تغترّوا بما لكم من الملك والملك، فإنّكم أسراء في قبضة قدرة مالك يوم الدين. ويا أيّها الرعيّة، إن كنتم تخافون سياسة الملك، أفما تخافون سياسة ملك الملوك الّذي هو مالك يوم الدين؟!
ومنها : أنّه ملك لا يشبه سائر الملوك، لأنّهم إذا تصدّقوا بشيء انتقص ملكهم، وقلّت خزائنهم، أمّا الحقّ سبحانه، فملكه لا ينتقص بالعطاء والإحسان.
ومنها : أنّه يجب على الرعيّة طاعته، فإن خالفوه ولم يطيعوه وقع الهرج والمرج في العالم، وحصل الاضطراب والتشويش، وتداعى ذلك تخريب
__________________
(١) آل عمران : ٢٦.
(٢) النبأ : ٣٨.
العالم، وفناء الخلق، فلمّا شاهدتم أنّ مخالفة الملك المجازي تفضي آخر الأمر إلى تخريب العالم وفناء الخلق، فانظروا إلى مخالفة ملك الملوك ؛ كيف يكون تأثيرها في زوال المصالح، وحصول المفاسد.
وتمام تقريره أنّه تعالى بيّن أنّ الكفر سبب لخراب العالم، قال تعالى :( تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبالُ هَدًّا * أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمنِ وَلَداً ) (١) وبيّن أنّ طاعته سبب للمصالح، قال :( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْها لا نَسْئَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعاقِبَةُ لِلتَّقْوى ) (٢) فيا أيّها الرّعية، كونوا مطيعين لمولاكم، ويا أيّها الملوك، كونوا مطيعين لملك الملوك حتّى تنتظم مصالح العالم. انتهى كلامه ملخّصا(٣) .
وفي تقديم الخبر إشارة إلى اختصاص الملكيّة به تعالى، وأنّه ملك الملوك، وسلطان السلاطين، وإيماء إلى برهان استحقاق التعظيم والعبوديّة، ووجوب إطاعته في أوامره ونواهيه، فإذا دلّ العقل على وجوب إطاعة الملك المجازي، فدلالته على وجوب إطاعة ملك الملوك الحقيقيّ أوضح وأتمّ. وفي الإتيان بجملة الصلة الاسميّة، إشارة إلى دوام مضمونها وثباته.
وقوله :( وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) جملة حاليّة غير منتقلة، وإن غلب الانتقال في الأحوال لدوام صفاته تعالى وثباتها أزلا وأبدا، وهي في الحقيقة مبنيّة للجملة السابقة، بل برهان لمضمونها، وإشارة إلى أنّه تعالى كما هو
__________________
(١) مريم : ٩٠ ـ ٩١.
(٢) طه : ١٣٢.
(٣) التفسير الكبير ١ : ٢٣٨ ـ ٢٤٠.
ملك حقيقيّ، كذلك ملكه ملك حقيقيّ دائميّ سرمديّ، لعموم قدرته على كلّ ما حوته بقعة الإمكان ممّا يصدق عليه لفظ الشيء، وهو ما أمكن وجوده بالإمكان العامّ دون ما امتنع وجوده، فإنّ الشيئيّة تساوق الوجود، وتخصيص التفسير بالإنعام والانتقام ـ كما في مجمع البيان(١) ـ لا وجه له.
وفسّر البيضاويّ «كلّ شيء» بكلّ ما يشاء، ويستفاد من بعض الأخبار أنّ الشيء هو ما قدّر وما كوّن، وهو ما روي عن الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى :( أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً ) (٢) أنّه قال : أي لا مقدّرا ولا مكوّنا(٣) . وربّما يفسّر الشيء في الآية بما يصحّ أن يكون مقدورا له تعالى، قيل : وهو أخصّ من قولنا «وهو بكلّ شيء عليم» لأنّه لا شيء إلّا ويجب أن يعلمه إذ لا شيء إلّا ويصحّ أن يكون معلوما في نفسه ولا يوصف سبحانه بكونه قادرا على ما لا يصحّ أن يكون مقدورا في نفسه ؛ مثل ما تقضّى وقته ممّا لا يبقى.
وصرّح بعضهم بأنّه يجوز إطلاق الشيء على المعدوم والمحال كشريك الباري. ومن هنا قال بعضهم : كيف قيل : «على كلّ شيء قدير» وفي الأشياء ما لا تعلّق به للقادر ؛ كالمستحيل، وفعل قادر آخر؟
وأجيب عنه بأنّه مشروط في حدّ القادر أن لا يكون الفعل مستحيلا، فالمستحيل مستثنى في نفسه عند ذكر القادر على الأشياء كلّها، فكأنّه قال :
__________________
(١) مجمع البيان ١٠ : ٤٠٨.
(٢) مريم : ٦٧. وفي المصدر : ولقد خلقنا الإنسان من قبل ولم يك شيئا وهو خلط بين الآيتين.
(٣) الكافي ١ : ١٤٧.
على كلّ شيء مستقيم قدير، وسيأتي لهذا زيادة توضيح.
والتحقيق : أن يقال : إنّا إن اعتبرنا في صدق الشيء إمكان الوجود الخارجيّ، فلا يطلق على المعدوم والمحال، وإن اعتبرنا إمكان الوجود بنحو من الأنحاء ولو في ظرف الذهن كما هو الحقّ، فلا مانع من إطلاقه على ما ذكر ؛ إذ من الواضح أنّ لكلّ لفظ ـ حتّى شريك الباري ـ مفهوما يدلّ عليه هذا اللفظ، وإلّا لكان هذا اللفظ من الألفاظ المهملة، ولذا قسّموا الكلّيّ إلى ما امتنع وجوده في الخارج، وما أمكن.
وهل يجوز إطلاق الشيء على الله سبحانه؟ قيل : لا، لأنّه قال :( اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ) (١) فلو كان شيئا لزم أن يكون خالق نفسه، فيكون حادثا مخلوقا، والمفروض قدمه وسابقيّته على الأشياء كلّها، ومثله الآية المبحوث عنها، فإنّه يلزم كونه مقدورا، والمفروض أنّه على كلّ شيء قدير، ولقوله تعالى :( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) (٢) فإنّه تعالى حكم بأنّ مثل مثله ليس بشيء، ولا شكّ أنّ كلّ شيء مثل لمثل نفسه، وثبت بهذه الآية أنّ مثل مثله ليس بشيء، فهو تعالى غير مسمّى بالشيء.
ولأنّ أسماء الله يفيد كلّ منها صفة جمال أو صفة جلال. وبعبارة : مفيد لمدح وكمال، ولا مدح في وصف شيء بشيء، فينتج أنّ لفظ الشيء ليس من أسماء الله.
ولأنّ هذا اللفظ في غاية الحقارة، فكيف يخاطب من هو أعظم من كلّ شيء.
__________________
(١) الزمر : ٦٢.
(٢) الشورى : ١١.
ولأنّ أسماء الله توقيفيّة، ولم ينقل عن النبيّ صلّى الله عليه وآله ولا عن أصحابه مخاطبة الله بلفظ «يا شيء».
ولأنّه تعالى قال :( وَلِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ ) (١) وهذا اللفظ لم يذكر في أسمائه الحسنى، فمن دعاه بلفظ الشيء فقد ألحد في أسمائه.
وفي جميع هذه الوجوه نظر :
أمّا الأوّل، فلأنّ العامّ يخصّص، وقد اشتهر أنّه «ما من عامّ إلّا وقد خصّ»، ولا يلزم أن يكون المخصّص لفظا، فقد يكون التخصيص بالعقل، وقد يكون بالإجماع، وقد يكون بالعرف والعادة، وقد يكون بغير ذلك.
والعقل والضرورة قاضيان في المقام بالتخصيص ؛ كما لا يخفى.
والجواب عن الثاني : أنّ الكاف زائدة، فتدبّر.
وعن الثالث : ما ذكره النيسابوريّ في تفسيره من أنّ الشيء خير من لا شيء، قال : وإن كان سائر الأشياء مشتركة معه في ذلك كالموجود والكريم والحليم، فإنّ كلّا منها مدح بالنسبة إلى من لا وجود له ولا كرم ولا حلم، بل الشيء بالحقيقة هو وباقي الأشياء شيئيّتها مستعارة كوجودها. انتهى، فتأمّل.
وعن الرابع : بالمنع، كيف وشيئيّة كلّ شيء بحسبه، وشيئيّة الحقّ سبحانه أعظم من جميع الشيئيّات، هذا مع ما عرفت من أنّ الشيئيّة مساوقة للوجود، ولم يختلف المسلمون في جواز إطلاقه عليه.
__________________
(١) الأعراف : ١٨٠.
وعن الخامس : أنّ التوقيفيّة لو سلّمت فهي في الأعلام الموضوعة دون الدعاء، فإنّه لا مانع منه إذا لم يشتمل على ما نهي عنه، وقد ورد أنّ خير الدعاء ما جرى باللسان. فتأمّل.
وعن السادس : أنّ المراد بالأسماء الحسنى ما اشتمل على نوع من المدح، ولم يشتمل على ما هو تعالى منزّه عنه. فليتأمّل.
فالحقّ الموافق للأكثرين جواز الإطلاق، وقد قال تعالى :( قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللهُ ) (١) وقال :( كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ) (٢) وفي رواية هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام : إنّه قال للزنديق حين سأله ما هو؟ قال : هو شيء بخلاف الأشياء، ارجع بقولي [شيء] إلى إثبات معنى، وأنّه شيء بحقيقة الشيئيّة غير أنّه لا جسم ولا صورة(٣) إلى آخره.
قال الرازيّ : واعلم أنّ من الناس من ظنّ أنّ هذا البحث واقع في المعنى، وهذا في غاية البعد، فإنّه لا نزاع في أنّ الله موجود وذات وحقيقة، إنّما النزاع في أنّه هل يجوز إطلاق هذا اللفظ عليه، فهذا نزاع في مجرّد اللفظ، ولا يجري بسببه تكفير ولا تفسيق، فليكن الإنسان عالما بهذه الدقيقة حتّى لا يقع في الغلط. انتهى.
وكيف كان، فكلّ شيء عامّ يشمل جميع ما يصلح أن يخبر عنه، وأن يعلم به سواء كان خيرا أو شرّا، نورا أو ظلمة.
__________________
(١) الأنعام : ١٩.
(٢) القصص : ٨٨.
(٣) التوحيد، للصدوق : ٢٤٣.
و «القدير» و «القادر» بمعنى، إلّا أنّ الأوّل لا يطلق على غير الله ؛ دون الثاني. قال أبو البقاء : القدير هو الفاعل لما يشاء على قدر ما تقتضيه الحكمة لا زائدا عليه، ولا ناقصا عنه، ولذا لا يصحّ أن يوصف به إلّا الله.
والمراد بالقدرة التمكّن من التأثير في الشيء بالإيجاد والإفناء وغيرهما، فالقادر على ما في شرح الطوالع وغيره : هو الّذي يصحّ أن يصدر عنه الفعل، وأن لا يصدر. قيل : وهذه الصفة هي القدرة، وإنّما يترجّح أحد الطرفين على الآخر بانضياف وجود الإرادة أو عدمها إلى القدرة. وقد يفسّر «القدرة» بكون الفاعل بحيث إن شاء فعل مع تمكّنه من الترك، و «القادر» بالّذي يصحّ أن [يؤثّر] تارة، وأن لا يؤثّر أخرى بحسب الدواعي المختلفة. وربّما يفسّر بالّذي إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل.
وقيل : إنّ هذا، تفسير المختار ويقابل القدرة الإيجاب، وهو كون الشيء بحيث يكون الفعل لازما لذاته، لا ينفكّ عنه ؛ كالإضاءة للشمس، والإحراق للنار، ويقابل «القادر» «الموجب» بفتح الجيم، وهو الّذي يصدر الفعل عنه لا باختياره، ولا يتمكّن من تركه.
وكيف كان، فلا ريب أنّه تعالى قادر مختار، لأنّه خلق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما من الصنائع الغريبة، والبدائع العجيبة، ولم يعي بخلقهنّ، ولا ريب أنّ وجود العالم بعد عدمه ينافي كون تأثيره تعالى فيه بالإيجاب، والقول بقدم العالم ـ كما عن الفلاسفة ـ شطط من الكلام ـ كما حقّق في محلّه ـ كالقول بأنّه سبحانه موجب بالذات، وأنّ تأثيره في وجود العالم بالإيجاب، بمعنى أنّ العالم لازم لذاته كتأثير الشمس في الإضاءة،
والنار في الإحراق، والماء في التبريد، وإن استدلّ له بأنّ المؤثّر في وجود الشيء إن استجمع جميع ما لا بدّ منه في المؤثّريّة من الشرائط وجوديّا كان أو عدميّا وجب الأثر، لأنّه لو لم يجب الأثر مع وجود المؤثّر المستجمع للشرائط لكان فعله تارة وتركه أخرى ترجيحا بلا مرجّح، واللازم باطل، فالملزوم مثله.
وإن لم يستجمع المؤثّر الشرائط المعتبرة في المؤثّر امتنع وجود الأثر، لامتناع المشروط عند عدم الشرط.
وفيه أوّلا : أنّ القادر يرجّح أحد مقدوريه على الآخر، كما أنّ الجائع يختار أحد الرغيفين المتساويين من جميع الوجوه، والهارب من السبع أو العدوّ يهرب من أحد الطريقين.
وثانيا : أنّ من الشرائط ؛ إرادة المؤثّر في وقت خاصّ وتحقّق المصلحة، وقوله :( عَلى كُلِّ شَيْءٍ ) يفيد عموم قدرته على جميع الممكنات، لأنّ لفظة «كلّ» من ألفاظ العموم موضوعة له خاصّة على الأظهر الأشهر، فاستعماله في غيره مجاز، وهو خير من الاشتراك، وإن ذهب إليه بعض. والدليل على عموم قدرته تعالى أنّ الموجب للقدرة ذاته المقدّسة، ونسبة الذات إلى كلّ الممكنات على السواء، لمكان تجرّده، فلو اختصّت قادريّته بالبعض دون البعض افتقر ذاته في كونه قادرا على البعض دون البعض إلى مخصّص، وهو محال، لمكان غناه عمّا سواه.
قال في شرح الطوالع : والمصحّح للمقدوريّة هو الإمكان المشترك بين جميع الممكنات، لأنّ ما عدا الإمكان منحصر في الوجوب والامتناع، وهما
يحيلان المقدوريّة. انتهى.
وقد ظهر من ذلك فساد ما ذهب إليه جماعة من الحكماء من أنّ الواحد لا يصدر عنه إلّا الواحد، وصرّح بعضهم بأنّ الله تعالى خلق العقل الأوّل المعبّر عنه بالصادر الأوّل، وقد كان واحدا بسيطا، وقد صدر عنه العقل الثاني والفلك الأوّل وهكذا إلى العقل العاشر، وهو خلق الفلك التاسع وهيولى العناصر.
وصرّح بعض المنجّمين بأنّ مدبّر هذا العالم ؛ أي عالم العنصريّات وهو ما تحت فلك القمر هو الأفلاك والكواكب وأوضاعها، لما يشاهد من أنّ تغيّرات أحوال هذا العالم ترتبط بتغيّرات أحوال الكواكب وأوضاعها، فإن أرادوا أنّ ذلك لم يتحقّق في الخارج ولكنّه مقدور فلا نزاع ؛ إذ القدرة على الشيء لا تستلزم الوقوع الخارجيّ، وإن أرادوا أنّه تعالى لا يقدر على إيجاد الكثير بلا واسطة وترتيب، فيدفعه ما تقدّم من الأدلّة على عموم قدرته تعالى. أللّهمّ إلّا أن يدّعى أنّ العقل يستحيل تحقّق ذلك، فلا تتعلّق القدرة بالمحال ؛ نظير تعلّق القدرة بإيجاد شريك الباري تعالى، فإنّه محال لعدم قابليّة المحال لهذا التعلّق، فيرجع الكلام إلى أنّ هذا من المحال، أو من الممكنات القابلة لتعلّق القدرة بها. وهذه مسألة أخرى ينبغي التأمّل فيها. فافهم.
وكذا الكلام في أنّه تعالى هل يقدر على فعل القبيح وإن لم يفعله لمانع الحكمة، فلا تكون القدرة زائلة بالنسبة إليه، فإنّ القبيح حينئذ يكون محالا ممتنعا بغيره، والمحال بغيره ممكن لذاته، والممكن لذاته مقدور، فكونه مقدورا بالذات لا ينافي الامتناع بالغير، أو لا يقدر على خلق القبيح بالذات
كما عليه إبراهيم النظّام من المعتزلة، قال : لأنّ فعل القبيح محال، والمحال غير مقدور، أمّا أنّ فعل القبيح ومحال، فلأنّه يدلّ على جهل الفاعل أو حاجته وهما محالان على الله، والمؤدّي إلى المحال محال، وأمّا أنّ المحال غير مقدور، فلأنّ المقدور هو الّذي يصحّ إيجاده، وذلك يستدعي صحّة الوجود، والممتنع ليس له صحّة الوجود.
وأجيب عنه :
أوّلا : إنّه لا قبيح بالنسبة إلى الله. فتأمّل.
وثانيا : بما تقدّم من أنّ المانع من فعله متحقّق لا أنّ القدرة زائلة، إلى آخر ما ذكر آنفا.
وكذا الكلام في أنّه تعالى هل يقدر على مثل فعل العبد ومقدوره لعموم القدرة، أو يقدر مثل فعل العبد ولكنّه ليس بقادر على نفس مقدور العبد ؛ كما عليه الشيخ أبو عليّ الجبّائيّ ـ نسبة إلى الجباء وهو بلده ـ وابنه أبو هاشم الجبّائيّ قالا : لأنّ المقدور من شأنه أن يوجد عند توفّر دواعي القادر، ويبقى على العدم عند توفّر صوارفه، فلو كان نفس مقدور العبد مقدورا لله، فلو أراد الله مقدور العبد وكرهه العبد لزم وقوعه لتحقّق الداعي، ولزم لا وقوعه، لتحقّق الصارف.
واعترض عليه بأنّ مكروه العبد لا يقع عند وجود الصارف إذا لم تتعلّق به إرادة الله المستقلّة. فليتأمّل.
أو لا يقدر على مثل فعل العبد ؛ كما عليه أبو القاسم البلخيّ قال : لأنّ مقدور العبد إمّا طاعة، أو سفه، أو عبث، وذلك على الله محال.
قال في شرح الطوالع : وأجيب بأنّ الفعل في نفسه حركة أو سكون، وكونه طاعة أو سفها أو عبثا اعتبارات تعرض للفعل بالنسبة إلى العبد، فإنّها تعرض للفعل من حيث إنّه صادر عن العبد، والله قادر على مثل ذلك الفعل. فتأمّل.
وكذا الكلام في أنّه تعالى هل يقدر على خلق الشرّ والظلمة ونحوهما، فهو خالق الخير والشرّ، وجاعل الظلمات والنور، لعموم قوله :( اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ) (١) وقوله :( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ) (٢) وقوله :( وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِباساً ) (٣) وقوله تعالى :( إِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ ) (٤) وقوله في الحديث القدسيّ : خلقت الخلق، وخلقت الخير، فطوبى لمن أجريت الخير على يديه، لا إله إلّا أنا، خلقت الخلق، وخلقت الشرّ، فويل لمن أجريت الشرّ بيديه، وويل لمن يقول كيف هذا، وكيف ذاك، أو لا يقدر إلّا على الخيرات والأنوار والنافعات، ولا يقدر على خلق الشرور والظلمات والمضرّات والمؤذيات(٥) .
كما هو مذهب الثنويّة والمجوس، فإنّهم يقولون : لو كان الله قادرا على الشرّ خالقا له لكان شرّيرا.
__________________
(١) الزمر : ٦٢.
(٢) الأنعام : ١.
(٣) النبأ : ١٠.
(٤) النساء : ٧٨.
(٥) وجدنا ما هو قريب منه في بحار الأنوار ٥ : ١٦٠.
ولكن عن صاحب التخليص أنّهم يقولون : إنّ فاعل الخير يزدان، وفاعل الشرّ أهرمن، ويعنون بهما ملكا وشيطانا، والله منزّه عن فعلي الخير والشرّ.
والمانويّة يقولون : إنّ فاعلهما النور والظلمة.
والديصانيّة يذهبون إلى مثل ذلك.
والجميع يقولون : إنّ الخير هو الّذي يكون جميع أفعاله خيرا، والشرّ هو الّذي يكون جميع أفعاله شرّا، ومحال أن يكون فاعل واحد وأفعاله كلّها خير وشرّ معا. انتهى ما حكي عن التلخيص.
وقال الملّا صدرا الشيرازيّ رحمه الله في شرحه على أصول الكافي : إنّ الثنويّة فرق كثيرة منهم المجوس أثبتوا أصلين مدبّرين قديمين يقتسمان الخير والشرّ، والنفع والضرر، والصلاح والفساد، يسمّون أحدهما النور، والثاني الظلمة، وبالفارسية : يزدان وأهرمن، ولهم تفصيل.
مذهب ومسائل المجوس كلّها تدور على قواعد النور والظلمة ولهم فيها قاعدتان عمدتان إحداهما بيان سبب امتزاج النور بالظلمة، وذكروا في ذلك وجوها كثيرة يطول الكلام بذكرها :
منها : إنّهم قالوا : إنّ يزدان فكّر في نفسه أنّه لو كان لي منازع كيف يكون؟ وهذه الفكرة كانت رديّة غير مناسبة لطبيعة النور، فحدثت الظلمة من هذه الفكرة، وسمّي أهرمن وكان مطبوعا على الشرّ والضرر والفساد.
ومنها : إنّ النور أبدع أوّلا أشخاصا من النور كلّها روحانيّة نورانيّة ربّانيّة، ولكنّ الشخص الأعظم الّذي اسمه زرزان شكّ في شيء من الأشياء، فحدث أهرمن الشيطان من ذلك الشكّ.
ومنها : إنّ زرزان الكبير قام فزمزم تسعة آلاف وتسعة وتسعين سنة ليكون له ابن، فلم يكن، ثمّ حدّث في نفسه وفكّر وقال : لعلّ هذا العلم ليس بشيء فحدث أهرمن من ذلك الهمّ الواحد، وزعموا أنّ الدنيا كانت سليمة من الشرور والآفات، وكان أهلها في خير محض، ونعيم خالص، فلمّا حدث أهرمن حدثت الشرور والآفات والفتن، ومنها غير ذلك.
والقاعدة الثانية : في سبب خلاص النور من الظلمة، ولهم في هذا أيضا وجوه كثيرة :
منها : إنّه وقعت المحاربة بين عسكر النور وعسكر الظلمة مدّة كثيرة من ألوف السنين، ثمّ يظفر عاقبة الأمر يزدان وجنوده وعند الظفر وإهلاك جنود أهرمن أجمعين تكون القيامة، فيرتفع هؤلاء إلى عالم النور والسماء، وينحطّ هؤلاء إلى الهاوية ودار الظلمة والجحيم، فذلك سبب الامتزاج، وهذا سبب الخلاص.
ومنها : إنّ الملائكة توسّطوا بعد المحاربة وصالحوا على أنّ العالم السفليّ خالص لجنود أهرمن، والعالم العلويّ خالص لجنود يزدان، ومنها غير ذلك من الوجوه الركيكة.
ومنهم الكيومرثيّة : أثبتوا أصلين ـ كما ذكرنا ـ إلّا أنّ المجوس الأصليّة لا يجوّزون أن يكونا قديمين أزليّين، فقالوا : النور أزليّ، والظلمة محدثة، ثمّ لهم اختلاف في سبب حدوثها أمن النور حدثت والنور لا يحدث شرّا جزئيّا، فكيف يحدث أصل الشرّ أي الظلمة أم شيء آخر، ولا شيء يشارك النور في القدم والإحداث.
ومنهم الزرادشتيّة : أصحاب زرادشت ـ وكان أصل دينه عبادة الله، والإيمان به، والكفر بالشيطان، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، إلّا أنّ أهل زمانه قتلوه وأحرقوا كتابه ـ فقال المنتسبون إليه : إنّ النور والظلمة أصلان متضادّان، وكذلك يزدان وأهرمن وهما مبدءا موجودات العالم، وحصلت التراكيب من امتزاجهما، والباري خالق النور والظلمة ومبدعهما، وهو واحد لا شريك له، ولا ضدّ ولا ندّ، لكنّ الخير والشرّ والصلاح والفساد والطهارة والخبث إنّما حدثت من امتزاج النور والظلمة، وهما متقاربان متغالبان، إلّا أن يغلب النور الظلمة والخير الشرّ، ثمّ يتخلّص الخير إلى عالمه، والشرّ ينحطّ إلى عالمه، وذلك هو سبب الخلاص، والباري مزجهما وخلطهما لحكمة رآها في التركيب، ومن هؤلاء من جعل النور أصلا وقال : وجوده وجود بالذات، وأمّا الظلمة فتبع كالظلّ بالنسبة إلى الشخص.
ومنهم الثنويّة بالحقيقة، وهؤلاء أصحاب المبدأين الأزليّين : يزعمون أنّ النور والظلمة أزليّان قديمان، بخلاف المجوس، فإنّهم قالوا بحدوث الظلام ـ كما مرّ ـ وهؤلاء قالوا بتساويهما في القدم، واختلافهما في الجوهر والطبع، والفعل والحيّز، والمكان والأجناس، والأبدان والأرواح، وبيّنوا كلّها على التفصيل،وربّماوضعوها في جدول سمّوه«جدول النور والظلمة».
فمن هؤلاء المانويّة أصحاب ماني الّذي ظهر في زمان شاپور بن أردشير، وقتله هرمز بن شاپور بعد عيسى عليه السلام أحدث دينا بين المجوسيّة والنصرانيّة ؛ كان يقول بنبوّة عيسى عليه السلام ولا يقول بنبوّة موسى عليه السلام زعم أنّ العالم مصنوع مركّب من أصلين قديمين أحدهما
نور، والآخر ظلمة، وأنّهما أزليّان لم يزلا ولا يزالا، وأنكر وجود شيء لا من أصل قديم.
ثمّ اختلف المانويّة في المزاج وسببه، قال بعضهم : إنّ النور والظلام امتزجا بالبخت والاتّفاق، لا بالقصد والاختيار. وقال أكثرهم : إنّ سبب المزاج أنّ أبدان الظلمة تشاغلت عن روحها بعض التشاغل، فنظرت فرأت النور فتغلّبت الأبدان على ممازجة النور، فأجابتها لإسراعها إلى الشرّ، فلمّا رأى ذلك ملك النور وجّه إليها ملكا من الملائكة في خمسة أجزاء من أجناسها الخمسة، فاختلطت الخمسة النوريّة بالخمسة الظلمانيّة، فخولط الدخان بالنسيم، والحريق بالنار، والنور بالظلمة، والسموم بالريح، والضباب بالماء، فما في العالم من منفعة وخير وبركة فمن أجناس النور، وما فيه من مقابلات هذه فمن أجناس الظلمة، إلى غير ذلك من مقالاتهم الطويلة.
ولكن عمدة شبههم ما ذكرناه من قبل، وهي أنّ في هذا العالم يوجد شرور وخيرات، والمبدأ الواحد لكونه بسيط الحقيقة لا يمكن أن يكون مبدأ لهما جميعا، وإلّا لكان شيء واحد خيرا وشرّا معا وهو محال، فمبدأ الخيرات هو يزدان، ومبدأ الشرور أهرمن، وقد ذكرنا وجه دفعها. انتهى كلامه.
وقد فصّل وجه الدفع في شرح الحديث الأوّل من أحاديث باب الخير والشرّ بما لا مزيد عليه، وحاصله يرجع إلى أنّ الشرّ الحقيقيّ ليس موجودا في العالم ؛ كما قال المولويّ :
پس بد مطلق نباشد در جهان |
[بد به نسبت باشد اين را هم بدان](١) |
قال بعض المتكلّمين في جوابهم : إنّ الخير والشرّ لا يكونان لذاتيهما خيرا وشرّا، بل بالإضافة إلى غيرهما، وإذا أمكن أن يكون شيء واحد بالقياس إلى واحد خيرا، وبالقياس إلى غيره شرّا، أمكن أن يكون قليل ذلك الشيء واحدا.
وكيف كان، فلا ريب في أنّه سبحانه على كلّ شيء قدير. نعم، لا تتعلّق قدرته بالمحال والممتنع وجوده بالذات، فإنّه لو فرض تأثير الحقّ فيه يكون ممكنا، بل واجبا بالغير، فينقلب الممتنع إلى الواجب. وهذا خلف.
وإلى هذا يشير ما روي عن الصادق عليه السلام أنّه قال : قيل لأمير المؤمنين عليه السلام : هل يقدر ربّك أن يدخل الدنيا في بيضة من غير أن يصغّر الدنيا أو يكبّر البيضة؟ فقال(٢) : إنّ الله تبارك وتعالى لا ينسب إلى العجز، والّذي سألتني لا يكون(٣) .
وفي رواية أخرى عنه عليه السلام أنّه : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : أيقدر الله أن يدخل الأرض في بيضة ولا يصغّر الأرض ولا يكبّر البيضة؟ فقال له(٤) : ويلك! إنّ الله لا يوصف بالعجز، ومن أقدر ممّن
__________________
(١) المثنويّ، للمولويّ : بداية الدفتر الرابع.
(٢) في المصدر : قال.
(٣) التوحيد : ١٣٠.
(٤) ليست في المصدر.
يلطّف الأرض ويعظّم البيضة(١) .
وفيه دلالة على ما قيل على أنّ إدخال العظيم في الصغير لا يمكن إلّا بأن يصغّر العظيم، أو يعظّم الصغير ؛ بنحو التكاثف والتخلخل، وما يجري مجراهما، وأنّ تصغير الأرض إلى حدّ تدخل في بيضة، أو تعظيم البيضة إلى حدّ تدخل فيها الأرض غاية القدرة.
وأمّا ما رواه محمّد بن [أبي] إسحاق [الخفّاف] أنّ عبد الله الديصانيّ سأل هشام بن الحكم فقال له : ألك ربّ؟ فقال : بلى. فقال : أقادر هو؟ قال : نعم قادر هو. قال : يقدر أن يدخل الدنيا كلّها في بيضة لا يكبّر البيضة ولا يصغّر الدنيا؟ قال هشام : النظرة. قال له : قد أنظرتك حولا، ثمّ خرج عنه، فركب هشام إلى أبي عبد الله عليه السلام فاستأذن عليه، فأذن له، فقال له : يا ابن رسول الله، أتاني عبد الله الديصانيّ بمسألة ليس المعوّل فيها إلّا على الله وعليك. فقال له أبو عبد الله عليه السلام : عمّا ذا سألك؟ فقال : قال لي كيت وكيت. فقال عليه السلام : كم حواسّك؟ قال : خمس. قال : أيّها أصغر؟ قال : الناظر. قال : وكم قدر الناظر؟ قال : مثل العدسة أو أقلّ منها. فقال له : يا هشام، فانظر أمامك وفوقك وأخبرني بما ترى. فقال : أرى سماء وأرضا ودورا وقصورا وبراري وجبالا وأنهارا. فقال عليه السلام : إنّ الّذي قدر أن يدخل الّذي تراه العدسة أو أقلّ منها قادر أن يدخل الدنيا كلّها البيضة ؛ لا يصغّر الدنيا، ولا يكبّر البيضة(٢) إلى آخره.
__________________
(١) التوحيد : ١٣٠.
(٢) التوحيد : ١٢٢ مع اختلاف في بعض الألفاظ.
فقد ذكر شارح الكافي المشار إليه : أنّ الّذي أفاده عليه السلام وجه إقناعيّ مبناه على المقدّمة المشهورة لدى الجمهور ؛ أنّ الرؤية بدخول المرئيّات في العضو البصريّ، فاكتفى في الجواب بهذا القدر، لقبول الخصم وتسليمه. انتهى.
وقال أيضا : واعلم بأنّ معنى كونه تعالى قادرا على كلّ شيء أنّ كلّ ما له ماهيّة(١) إمكانيّة أو شيئيّة تصوّرته فيصحّ تعلّق قدرته به، وأمّا الممتنعات فلا ماهيّة(٢) لها ولا شيئيّة حتّى يصحّ كونها مقدورة له تعالى، وليس في نفي مقدوريّتها نقص على عموم القدرة بل القدرة عامّة، والفيض شامل، والممتنع لا ذات له، وإنّما يخترع العقل في وهمه مفهوما يجعله عنوانا لأمر باطل بالذات كشريك الباري، واللّاشيء، واجتماع النقيضين إلى آخره. انتهى.
والحاصل : إنّ قابليّة المتعلّق للقدرة الإلهيّة للتأثّر بالقدرة شرط في تعلّق القدرة العامّة، والمحال ليس بقابل له أصلا، لأنّه لا ذات له، ولا شيئيّة. وقد أجاد من قال :
قبول ماده شرط است در إفاضه فيض |
وگرنه بخل نباشد بمبدأ فياض |
قال شارح الزيارة الجامعة : وقول المتكلّمين أنّ العلم أعمّ من القدرة، لأنّه يتعلّق بالممكن والواجب والممتنع، والقدرة إنّما تتعلّق بالممكن خاصّة جهل بعموم القدرة وخصوص العلم، لأنّ العلم هو القدرة، وإنّما
__________________
(١) في المصدر : مهيّة.
(٢) في المصدر : مهيّة.
يختلفان ويتعدّدان باعتبار المفهوم، وأمّا باعتبار المصداق فهو واحد، العلم نفس القدرة في نفس الأمر، وإنّما تعدّدا واختلفا باعتبار اختلاف متعلّقهما وجهته من حيث الفهم والإدراك، والمفهومان حادثان، وهما عنوان المعنى القديم الّذي هو واحد بكلّ اعتبار، فإنّا إن أردنا العلم القديم فهو الله، وإن أردنا العلم الحادث المرتبط بالمعلوم فهو المعلوم، أو صفة المعلوم، والأوّل غير مرتبط بشيء لأنّ ذاته غير مرتبطة بشيء، والأوّل ليس هو المعلوم، ولا صفة المعلوم، لأنّ ذاته ليس هو المعلوم الحادث، ولا صفته.
وإذا قلت : هو المعلوم القديم، وجب الاتّحاد، وامتنع التعدّد والكثرة ولو باعتبار الفرض والاحتمال والإمكان، والثاني ؛ أي العلم الحادث مرتبط بالمعلوم، لأنّه إمّا نفس المعلوم على قول، أو صفته على آخر، وإذا أردنا القدرة القديمة فهو الله، وإن أردنا الحادثة فهي المتعلّقة بالحادث، والممتنع ليس شيئا، فكما لا يكون مقدورا لا يكون معلوما، لأنّه لو كان معلوما لكان إمّا نفس العلم، فلا يكون ممتنعا، لأنّ العلم موجود، وإما موصوفا، والعلم صفة على القول الآخر بأنّ العلم صفة المعلوم، ويجب أن يكون على هذا الممتنع موجودا، لأنّ العلم صفته هي موجودة، ولا يجوز في العقول أن تكون الصفة موجودة والموصوف ممتنع الوجود. انتهى.
وحاصله : أنّ المحال كما لا تتعلّق به القدرة، كذلك لا يتعلّق به العلم، فأعمّيّة العلم ممنوعة. فتأمّل.
ثمّ أشار سبحانه إلى بعض آثار صنعه وقدرته، وأنّ قدرته تشمل الجواهر والأعراض، ولا تختصّ بالجواهر، فقال تعالى :( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ
وَالْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ) فإنّ الموت والحياة على ما صرّح به جماعة عرضان، والأعراض مخلوقة كالجواهر.
لا يقال : إنّ الموت عدم والخلق لا يتعلّق بالأعدام ؛ إذ العدم أزليّ لا تؤثّر فيه القدرة ؛ إذ المقدور منه هو إبقاؤه واستمراره، لما قيل من أنّ لأعدام الملكات حظّ ضعيف من الوجود، والموت هو عدم الحياة لمن شأنه الحياة ؛ نظير العمى الّذي هو عدم البصر لمن شأنه أن يكون بصيرا، فالتقابل بالعدم والملكة لا بالإيجاب والسلب، ولذا صحّ تعلّق الخلق به. فتأمّل.
هذا ؛ وفي رواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال : الحياة والموت خلقان من خلق الله، فإذا جاء الموت فدخل في الإنسان لم يدخل في شيء إلّا وقد خرجت منه الحياة(١) . انتهى.
وورد أنّه يؤتى بالموت ما بين الجنّة والنار على صورة كبش أملح فيذبح(٢) .
ويظهر من ذلك أنّ التقابل في الموت والحياة بالتضادّ كما يكشف عن ذلك تصريح بعضهم بأنّ الموت ضدّ الحياة، فهما أمران وجوديّان يتعلّق بهما الخلق والقدرة. فتأمّل.
هذا، ولكن في التفسير الصادقيّ عليه السلام يفسّر «خلق» بـ «قدّر»، قال عليه السلام : ومعناهما قدّر الحياة والموت( لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً )
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٥٩.
(٢) إشارة إلى ما جاء في تفسير القمّيّ ٢ : ٥٠ ؛ وفي بحار الأنوار ٨ : ٣٤٤.
أي يختبركم بالأمر والنهي أيّكم أحسن عملا(١) .
[و] في تفسير البيضاويّ : قدّرهما أو أوجد الحياة وأزالها حسبما قدّره(٢) .
وفي الكشّاف : إنّ الحياة ما يصحّ بوجوده الإحساس. وقيل : ما يوجب كون الشيء حيّا، وهو الّذي يصحّ منه أن يعلم ويقدر، والموت عدم ذلك فيه. قال : ومعنى خلق الموت والحياة : إيجاد ذلك المصحّح وإعدامه(٣) . انتهى.
ونقل في مجمع البحرين : أنّ الموت في كلام العرب يطلق على السكون، يقال : ماتت الريح : إذا سكنت، قال : والموت يقع بحسب أنواع الحياة :
فمنها : ما هو بإزاء القوّة النامية الموجودة في الحيوان والنبات ؛ كقوله :( يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها ) (٤) .
ومنها : زوال القوّة الحسّيّة ؛ كقوله :( يا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هذا ) (٥) .
ومنها : زوال القوّة العاقلة ـ وهي الجهالة ـ كقوله :( أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ ) (٦) و [قوله] :( إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى ) (٧) .
ومنها : الحزن والخوف المكدّر للحياة ؛ كقوله :( وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِ
__________________
(١) تفسير القمّيّ ٢ : ٣٧٨.
(٢) أنوار التنزيل وأسرار التأويل ٢ : ٥٠٩.
(٣) الكشّاف ٤ : ٥٧٥.
(٤) الروم : ١٩.
(٥) مريم : ٢٣.
(٦) الأنعام : ١٢٢.
(٧) النمل : ٨٠.
مَكانٍ وَما هُوَ بِمَيِّتٍ ) (١) ، وقد يستعار الموت للأحوال الشاقّة كالفقر والذلّ والسؤال والهدم وغير ذلك(٢) . انتهى.
ويستفاد من هذه العبارات أنّ التقابل بالعدم والملكة نظير المرض والصحّة. فتأمّل.
وفي كلّيّات أبي البقاء : الموت هو في الحقيقة جسم على صورة الكبش، كما أنّ الحياة جسم على صورة الفرس. وأمّا المعنى القائم بالبدن عند مفارقة الروح فإنّما هو أثره، فتسميته بالموت من باب المجاز ـ إلى أن قال ـ والإماتة : جعل الشيء عادم الحياة. انتهى.
وفي تفسير عرائس البيان في حقائق البيان : وأصل الحياة حياة نجلية، وأصل الممات موت استتارة، وهما يتعاقبان للعارفين في الدنيا، فإذا ارتفعت الحجب يرتفع الموت عنهم بأنّهم يشاهدونه عيانا بلا استتار أبدا، لا يجري عليهم طوارق الحجاب بعد ذلك، قال الله :( بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ) (٣) .
خلق الموت والحياة فيميت قوما بنعت الفناء في ظهور مسطوات الفناء، ويحيي قوما بنعت البقاء في ظهور أنواع البقاء ـ إلى أن قال ـ قال الجنيد : حياة الأجسام مخلوقة، وهي الّتي قال الله :( خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ ) وحياة الله قائمة لا انقطاع لها ؛ أوصلها إلى أوليائه في قديم الدهر الّذي ليس له
__________________
(١) إبراهيم : ١٧.
(٢) مجمع البحرين ٤ : ٢٤٦ (موت).
(٣) آل عمران / ١٦٩.
ابتداء بموادّه قبل أن خلقهم، فكانوا في علمه أحياء يراهم قبل إيجادهم، ثمّ أظهرهم فأعادهم الحياة المخلوقة، فكانوا في ستره بعد الوفاة كما كانوا، ثمّ ردّ عليهم الحياة الأبد فكانوا أحياء، واتّصل الأبد بالأبد فصار أبدا في الآبد ـ إلى أن قال ـ قال الواسطيّ : من أحياه الله عند ذكره في أزله لا يموت أبدا، ومن أماته في ذلك لا يحيا أبدا، وكم حيّ غافل عن حياته، وميّت غافل عن مماته. انتهى.
وحاصله أنّ المراد بالحياة تجلّي الحقّ على عبده بكشف الأستار، وبالممات احتجابه عنه، وحرمان العبد عن مشاهدة الأنوار، ومن هنا قيل بالفارسيّة :
هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق |
ثبت است بر جريده عالم دوام ما(١) |
وقد يقال : إنّ المراد بـ «الموت» الموت في الدنيا بالمعصية، و «الحياة» الحياة في الآخرة بالطاعة.
وقد يقال : إنّ المراد بالموت موت العبد عن العلائق الجسمانيّة، وعند ذلك يصير حيّا بالحياة الأبديّة ؛ كما قيل :
إذا شئت أن تحيا فمت عن علائق |
من الحسّ خمس ثمّ عن مدركاتها |
ومن هنا يظهر سرّ قوله :
__________________
(١) للشاعر حافظ الشيرازيّ.
اقتلوني يا ثقاتي إنّ في قتلي حياتي |
ومماتي في حياتي وحياتي في مماتي |
ولفظ الحياة في الآية وإن يشمل بإطلاقه حياة الله الّتي هي من الصفات الثبوتيّة، إلّا أنّ قوله :( خَلَقَ ) قرينة على إرادة غيرها، فإنّ حياة الله ليست مخلوقة. كيف وهي كالعلم والقدرة عين الذات على ما هو الحقّ، فإنّها عبارة عن صحّة اتّصافه بالقدرة والعلم ؛ كما صرّح به الحكماء وأبو الحسين البصريّ ؛ خلافا للأشاعرة، فصرّحوا بأنّها صفة زائدة على ذاته، مغايرة لهذه الصحّة. وهو كما ترى، والدليل على حياته أنّه تعالى قادر عالم فيكون حيّا بالضرورة.
وعن المعتزلة : إنّ الحياة عبارة عن صفة تقتضي صحّة اتّصافه تعالى بالعمل والقدرة، وإلّا لكان اختصاصه بها ترجيحا بلا مرجّح. وفيه : إنّ ذاته كاف في هذا التخصيص ممّا لا تتضمّن.
وكيف كان، فلا يخفى أنّ قوله :( خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ ) في قوّة قوله : «خلق الأشياء كلّها» كما قال :( اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ) (١) فإنّ الأشياء منحصرة في صنفين : الأحياء والأموات.
وبعبارة أخرى : هي إمّا ساكنة أو متحرّكة ولا ثالثة، وإنّما قدّم الموت على الحياة مع أنّها أشرف، وأنّ الموت طارئ عليها ووارد عليها، وأنّه روي عن الباقر عليه السلام : إنّ الله خلق الجنّة قبل أن يخلق النار، وخلق الطاعة قبل أن يخلق المعصية، وخلق الرحمة قبل الغضب، وخلق الخير قبل الشرّ، وخلق الأرض قبل السماء، وخلق الحياة قبل الموت، وخلق الشمس قبل
__________________
(١) الزمر : ٦٢.
القمر، وخلق النور قبل الظلمة(١) .
إمّا لأنّ الموت أمر عدميّ، والعدم سابق على الوجود. فتأمّل.
وإمّا لأنّ الموت في عالم الطبع مقدّم على الحياة بالطبع.
وإمّا لأنّ الاهتمام بذكر الموت في هذا المقام ؛ أي مقام ذكر المقدوريّة والمقهوريّة للخلق أشدّ، فكان تقديم ما هو أقرب إلى ذلك أنسب ؛ كما في تقديم السنة على النوم في قوله :( لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ ) (٢) وتقديم التجارة على اللهو في قوله :( وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً ) (٣) والعكس في قوله :( خَيْرٌ مِنَ اللهْوِ وَمِنَ التِّجارَةِ ) (٤) .
قال البيضاويّ : وقدّم الموت لقوله :( وَكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ) (٥) ولأنّه أدعى إلى حسن العمل. انتهى(٦) .
يعني أنّ الغرض من ذكر ذلك التهديد عن ارتكاب الشرور، والترغيب في حسن العمل، وارتكاب الخيرات، فتقديم ذكر الموت الرادع عن المعاصي، الحامل على الطاعات، أنسب وأولى في المقام.
وفي مجمع البيان قيل : إنّما قدّم ذكر الموت على الحياة، لأنّه إلى القهر أقرب ؛ كما قدّم البنات على البنين في قوله :( يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً ) (٧) وقيل :
__________________
(١) الكافي ٨ : ١٤٥.
(٢) البقرة : ٢٥٥.
(٣ و ٤) الجمعة : ١١.
(٥) البقرة : ٢٨.
(٦) أنوار التنزيل وأسرار التأويل ٢ : ٥٠٩.
(٧) الشورى : ٤٩.
إنّما قدّمه لأنّه أقدم، فإنّ الأشياء في الابتداء كانت في حكم الأموات ؛ كالنطفة والتراب(١) . انتهى.
وهذا راجع إلى بعض ما قدّمناه.
وربّما يخطر بخلدي أنّ الوجه في ذلك أنّ غرابة خلق الموت أكثر من غرابة خلق الحياة ولو بحسب ظنّ الناس وتوهّمهم، فلذا قدّمه في مقام ذكر أنّ بيده الملك، وأنّ له التصرّف في كلّ شيء، وأنّه على كلّ شيء قدير، ليكون إشارة إلى استواء نسبة قدرته إلى كلّ شيء، فلا يتصوّر أهون وأصعب في أفعاله تعالى ؛ بل الجميع بالنسبة إلى قدرته على حدّ سواء، فخلق النملة عنده كخلق الفيل، وإيجاده السماوات والأرضين وما بينهما مثل إيجاده الذرّة بلا تفاوت، فأمره( إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) (٢) وفي قوله في الجوشن الكبير : «يا من في الممات قدرته»(٣) . إشعار بهذا الوجه.
وقوله :( الَّذِي خَلَقَ ) محتمل لكونه استئنافا بيانيّا، لكونه جوابا عن السؤال المقدّر عن مقدار قدرته، ولكونه بدلا عن الّذي بيده الملك، ولكونه خبرا عن المبتدأ المحذوف ؛ أي هو الّذي خلق الموت.
وقوله :( لِيَبْلُوَكُمْ ) تعليل لخلق هذين الأمرين بالعلّة الغائيّة، وهذا التعليل مذكور أيضا في قوله تعالى في سورة هود :( هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ ) (٤) إلى آخره. أي :
__________________
(١) مجمع البيان ١٠ : ٤٠٨.
(٢) يس : ٨٢.
(٣) مفاتيح الجنان، دعاء الجوشن الكبير.
(٤) هود : ٧.
فائدة هذا الخلق هو الاختبار والامتحان ؛ إذ «عند الامتحان يكرم الرجل أو يهان» من بلاه يبلوه : إذا اختبره وامتحنه، وبمعناه : ابتلاه، والاسم «البلاء» كال «سلام» ومنه قوله :( إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ ) (١) .
قيل : البلاء على ثلاثة أوجه : نعمة واختبار ومكروه ؛ والاختبار حقيقة في أن يفعل الجاهل بحقيقة الأمر فعلا يريد أن يعلم به ما في نفس الأمر وحقيقته، ولا ريب أنّ هذا لا يصحّ بالنسبة إلى الله الّذي لا تخفى عليه الحقائق والعواقب، فالمراد به في الآية ونحوها معناه المجازي، وهو إظهار ما علمه لغيره ليطّلع عليه، لا ليعلم الله ما لم يعلم.
والحاصل : أنّ فائدة هذا الاختبار راجعة إلى المختبر الجاهل بحقيقة أمره، لا إلى المختبر بالكسر.
قال الطريحيّ : قوله :( وَنَبْلُوَا أَخْبارَكُمْ ) (٢) ؛ أي يختبرها، واختبار الله العباد : امتحانهم وهو عالم بأحوالهم فلا يحتاج أن يختبرهم [ليعرفهم]. قال : وتحقيق هذا المجاز أنّ الله يكلّف العباد ليثيب المحسن، ويجازي المسيء(٣) . انتهى.
ولذا قال البيضاويّ في تفسير هذه الآية : ليعاملكم معاملة المختبر بالتكليف(٤) . انتهى.
__________________
(١) الصافّات : ١٠٦.
(٢) محمّد صلّى الله عليه وآله : ٣١.
(٣) مجمع البحرين ١ : ٦١٨ (خبر).
(٤) أنوار التنزيل وأسرار التأويل ٢ : ٥٠٩.
ونحوه ما في مجمع البيان(١) .
وقال الزمخشري في الكشّاف : وسمّى علم الواقع منهم باختبارهم «بلوى» وهي الخبرة استعارة من فعل المختبر، ونحوه قوله تعالى :( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجاهِدِينَ مِنْكُمْ ) (٢) (٣) . انتهى.
وفي الكلّيّات : إنّ البلاء أصله الاختبار، وفي ذلك بلاء : أي محنة إن أشير إلى صنائعهم، أو نقمة إن أشير إلى الإنجاء. وفعل البلوى يتعدّى إلى مفعول واحد بنفسه، وإنّما يتعدّى إلى الثاني بواسطة الباء. انتهى.
وعلى ما ذكره من عدم تعدّي هذا الفعل بنفسه إلّا إلى المفعول الواحد، فلا تعلّق لقوله :( أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) إلّا أن يقال كما في الكشّاف :
إنّ قوله :( لِيَبْلُوَكُمْ ) تضمّن معنى العلم، فكأنّه قيل : ليعلمكم أيّكم أحسن عملا. قال : وإذا قلت علمته أزيد أحسن عملا أم هو، كانت هذه الجملة واقعة موقع الثاني من مفعوليه ؛ كما تقول : علمته هو أحسن عملا(٤) . انتهى.
وبه صرّح البيضاويّ أيضا قال :
جملة واقعة موقع المفعول الثاني لفعل البلوى المتضمّن معنى العلم(٥) . انتهى.
ويمكن أن يقال : لا تضمين في قوله :( لِيَبْلُوَكُمْ ) بل يقال : إنّ فعل
__________________
(١) مجمع البيان، المجلّد ٥ : ٤٨٤.
(٢) محمّد صلّى الله عليه وآله : ٣١.
(٣ و ٤) الكشّاف ٤ : ٥٧٥.
(٥) أنوار التنزيل وأسرار التأويل ٢ : ٥٠٩.
«العلم» محذوف بقرينة فعل «البلوى» فالتقدير «ليبلوكم فيعلم أيّكم أحسن عملا» كما صرّح به شيخنا الطبرسي رحمه الله(١) .
وعليه، ففي الكلام تعليق، وهو إبطال العمل لفظا خاصّة، فمحلّ هذه الجملة ؛ أي قوله :( أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) نصب، ولذا ينصب المعطوف عليها، وهو ـ أي التعليق في هذا الباب ـ واجب عند دخول واحد من المعلّقات على الجملة، وهي «ما» و «لا» و «إن» النافيات، و «لام» الابتداء والاستفهام.
قال السيوطيّ : سواء تقدّمت أداته على المفعول الأوّل نحو «علمت أزيد قائم أم عمرو» أم كان المفعول اسم استفهام نحو( لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى ) أم أضيف إلى ما فيه معنى الاستفهام نحو «علمت أبو من زيد» فإن كان الاستفهام في الثاني نحو «علمت زيدا أبا من هو»، فالأرجح نصب الأوّل، لأنّه غير مستفهم به، ولا مضاف إليه. قاله في شرح الكافية. انتهى.
بخلاف الإلغاء، وهو إبطال العمل لفظا ومحلّا بوقوع الفعل في الوسط، فإنّه جائز، وربّما يعدّ من المعلّقات «لعلّ» و «لو».
قال الطبرسيّ : وارتفع «أيّ» بالابتداء، وإنّما لم يعمل فيه ما قبله لأنّه على أصل الاستفهام(٢) . انتهى.
وأمّا على الأوّل فلا تعليق، قال في الكشّاف بعد ذكر ما تقدّم من العبارة :
فإن قلت أتسمّي هذا تعليقا؟ قلت : لا، إنّما التعليق أن توقع بعد ما يسدّ مسدّ المفعولين جميعا ؛ كقولك : «علمت أيّهما عمرو، وعلمت أزيد
__________________
(١) مجمع البيان ١٠ : ٤٠٧.
(٢) مجمع البيان ١٠ : ٤٠٧.
منطلق» ألا ترى أنّه لا فصل بعد سبق أحد المفعولين بين أن يقع ما بعده مصدرا بحرف الاستفهام، وغير مصدر به، ولو كان تعليقا لافترقت الحالتان ؛ كما افترقتا في قولك «علمت أزيد منطلق» و «علمت زيدا منطلقا(١) . انتهى.
وقال البيضاويّ بعد عبارته المتقدّمة :
وليس هذا من باب التعليق، لأنّه يخلّ به وقوع الجملة خبرا لما لا يعلّق الفعل عنها ؛ بخلاف ما إذا وقعت موقع المفعولين(٢) . انتهى.
وكلمة «أيّ» في الآية استفهاميّة معربة بالرفع على الابتدائيّة.
وقوله :( أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) قد حذف معادله، وهو : «وأيّكم أسوأ عملا» كما في قوله :( وَجَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ ) (٣) ؛ أي : والبرد. وفي الاكتفاء بذكر الأحسن عملا إشارة إلى أنّ المقصود الأصليّ من الخلق هو حسن العمل، ولا تنافي هذه الآية قوله :( وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ) (٤) فإنّ العبادة من أحسن العمل، والقرآن يكشف بعضه عن بعض، ومدخليّة الحياة في تحسين العمل واضحة، فإنّ بها يقتدر العبد على الأعمال الصالحة، وأمّا مدخليّة الموت فإنّ ذكره زاجر للعبيد عن المعاصي، وموجب لعدم الوثوق بالدنيا الّتي هي أسّ كلّ خطيئة، ورأس كلّ معصية.
وفسّر في العرائس( أَحْسَنُ عَمَلاً ) بالّذي يدركه التوفيق فيحييه بالطاعة في الدنيا، ويبعده عن المعصية.
__________________
(١) الكشّاف ٤ : ٥٧٥.
(٢) أنوار التنزيل وأسرار التأويل ٢ : ٥٠٩.
(٣) النحل : ٨١.
(٤) الذاريات : ٥٦.
وفي بعض الأخبار : أنّ المراد أيّكم أتمّ عقلا ؛ أي معرفة وخشية(١) من الله، فإنّ العقل ما عبد به الرحمن، واكتسب به الجنان(٢) .
وقد فسّر ليعبدون بـ «ليعرفون». وقد ورد في جملة من الروايات : أنّ ثواب العمل على مقدار المعرفة والعقل.
وفي رواية سليمان الديلميّ [عن أبيه] قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : فلان من عبادته ودينه وفضله كذا. فقال : كيف عقله؟ قلت : لا أدري. فقال : إنّ الثواب على قدر العقل، إنّ رجلا من بني إسرائيل كان يعبد الله في جزيرة من جزائر البحر، خضراء نضرة، كثيرة الشجر، طاهرة الماء، وإنّ ملكا من الملائكة مرّ به فقال : يا ربّ أرني ثواب عبدك هذا، فأراه الله ذلك فاستقلّه(٣) الملك، فأوحى الله إليه أن اصحبه، فأتاه الملك في صورة إنسيّ فقال له : من أنت؟ فقال : أنا رجل عابد بلغني مكانك وعبادتك في هذا المكان، فأتيتك لأعبد الله معك، فكان معه يومه ذلك، فلمّا أصبح قال له الملك : إنّ مكانك لنزه وما يصلح إلّا للعبادة. فقال له العابد : إنّ لمكاننا هذا عيبا. فقال له : ما هو؟ قال : ليس لربّنا بهيمة، فلو كان له حمار رعيناه في هذا الموضع، فإنّ هذا الحشيش يضيع. فقال له الملك : وما لربّك حمار؟ فقال : لو كان له حمار ما كان يضيع مثل هذا الحشيش. فأوحى الله إلى الملك : إنّما أثيبه على قدر عقله(٤) . انتهى.
__________________
(١) إشارة إلى رواية في البحار ٧٠ : ٢٣٢.
(٢) إشارة إلى حديث في الكافي ١ : ١١.
(٣) أي : رآه قليلا.
(٤) بحار الأنوار ١٤ : ٥٠٦.
وعن النبيّ صلّى الله عليه وآله : إذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في حسن عقله، فإنّما يجازى بعقله(١) . انتهى.
وعن الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية : ليس يعني أكثر عملا، ولكن أصوبكم عملا، وإنّما الإصابة خشية الله، والنيّة الصادقة [والحسنة] ثمّ قال : الإبقاء على العمل حتّى يخلص أشدّ من العمل(٢) انتهى.
وفي الكشّاف عند تفسير( أَحْسَنُ عَمَلاً ) : قيل : أخلصه وأصوبه، لأنّه إذا كان خالصا غير صواب لم يقبل، وكذلك إذا كان صوابا غير خالص، فالخالص أن يكون لوجه الله تعالى، والصواب أن يكون على السنّة.
وعن النبيّ صلّى الله عليه وآله أنّه تلاها، فلمّا بلغ قوله :( أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) قال : أيّكم أحسن عقلا، وأورع عن محارم الله، وأسرع في طاعة الله(٣) ، يعني أيّكم أتمّ عقلا عن الله، وفهما لأغراضه، قال : والمراد أنّه أعطاكم الحياة الّتي تقدرون بها على العمل، وتستمكنون منه، وسلّط عليكم الموت الّذي هو داعيكم إلى اختيار العمل الحسن على القبيح، لأنّ وراءه البعث والجزاء الّذي لا بدّ منه(٤) . انتهى.
وفي مصباح الشريعة : قال الصادق عليه السلام : ذكر الموت يميت الشهوات في النفس، ويقطع منابت الغفلة، ويقوّي القلب بمواعد الله، ويرقّ الطبع، ويكسر أعلام الهوى، ويطفئ نار الحرص، ويحقّر الدنيا ـ إلى
__________________
(١) الكافي ١ : ١١.
(٢) الكافي ٢ : ١٦.
(٣) انظر : بحار الأنوار ٧٠ : ٢٣٢.
(٤) الكشّاف ٤ : ٥٧٥.
أن قال ـ ومن لا يعتبر بالموت، وقلّة حيلته، وكثرة عجزه، وطول مقامه في القبر، وتحيّره في القيامة، فلا خير فيه(١) إلى آخره.
ولمّا كانت الآية مسوقة للترغيب على الطاعة، والترهيب عن المعصية والمخالفة، ختمها باسمي «العزيز» و «الغفور» لدلالة الأوّل على أنّه الغالب الّذي لا يعجزه من خالف أمره ونهيه، فلا ينقص من ملكه إساءة المسيء، وكفر الكافر، والثاني على أنّه لا ينبغي للعاصي أن ييأس من روحه ورحمته، فإنّه غفّار لمن تاب وعمل صالحا.
وفي العرائس : عن سهل أنّه قال في قوله تعالى :( وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ) الممتنع في ملكه، الغفور يستره بجوده.
( الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً ما تَرى فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ * ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ ) ويحتمل في ما قدّمناه وكونه نعتا للغفور ومبتدأ خبره ما ترى. وفيه أيضا برهان على كمال قدرته، وإشارة إلى بعض آثار نافذ مشيّته. وفي قوله( خَلَقَ ) ردّ على من زعم من الفلاسفة أنّ الأفلاك وأجرامها قديمة أزليّة بالذات والصفات ؛ كأرسطو، وأبي نصر الفارابيّ، ومن زعم أنّها قديمة الذات محدثة الصفات كتاليس الملطيّ، وانكساغورس، وفيثاغورس، وسقراط، وجميع فرق الثنويّة، فإنّ الخلق معناه الاختراع، ويلزمه الحدوث ؛ وعليه المسلمون كافّة، بل جميع أهل الملل إلّا بعض المجوس. وهذا مذهب أفلاطون على ما حكي عنه.
__________________
(١) مصباح الشريعة : ١٧١.
قال العلّامة المجلسيّ رحمه الله في البحار : إذا أمعنت النظر فيما قدّمناه، وسلكت مسلك الإنصاف، ونزلت عن مطيّة التعنّت والاعتساف، حصل لك [القطع] من الآيات المتضافرة، والأخبار المتواترة الواردة بأساليب مختلفة، وعبارات متفنّنة من اشتمالها على بيانات شافية، وأدلّة وافية ؛ بالحدوث بالمعنى الّذي أسلفناه، ومن تتبّع كلام العرب، وموارد استعمالاتهم، وكتب اللغة، يعلم أنّ الإيجاد، والإحداث، والخلق، والفطر، والإبداع، والاختراع، والصنع، والإبداء لا يطلق(١) إلّا على الإيجاد بعد العدم.
وقال المحقّق الطوسيّ في شرح الإشارات : إنّ أهل اللغة فسّروا الفعل بإحداث شيء ما(٢) . وقال أيضا : الصنع : إيجاد شيء مسبوق بالعدم، وفي اللغة : الإبداع : الإحداث، ومنه البدعة، لمحدثات الأمور. وفسّروا الخلق بإبداع شيء بلا مثال سابق.
وقال ابن سينا في رسالة الحدود : الإبداع اسم مشترك لمفهومين أحدهما تأسيس الشيء لا عن شيء [ولا بواسطة شيء]، والمفهوم الثاني أن يكون للشيء وجود مطلق عن سبب بلا متوسط، وله في ذاته أن يكون موجود(٣) إلى آخره. انتهى.
والخلق : يشمل التكوين والابتداع والاختراع، وقد اصطلح الحكماء على تسمية ما يفعله الله بالكائن إذا كان مسبوقا بالمادّة والمدّة ؛ كالعناصر
__________________
(١) في المصدر : تطلق.
(٢) ليست في المصدر.
(٣) بحار الأنوار ٥٧ : ٢٥٤.
والعنصريّات، فإنّها زمانيّة ومسبوقة بالهيولى، وبالمبتدع إذا لم يكن مسبوقا بشيء منهما ؛ كالعقول والنفوس المجرّدة، فإنّها سابقة على وجود الزمان والهيولى، وبالمخترع إذا كان مسبوقا بالمادّة دون المدّة ؛ كالفلك والفلكيّات، فإنّ المدّة قد حدثت بخلق الفلك، فإنّها عبارة عن مقدار حركته المتأخّرة عن خلق جرمه وجسمه، ولكنّه خلق من المادّة، ففي رواية : إنّ الله كان عرشه على الماء، ولم يخلق شيئا قبل الماء، فلمّا أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسما عليه فسمّاه سماء، ثمّ أيبس الماء فجعله أرضا واحدة، ثمّ فتقها فجعلها سبع أرضين في يومين(١) إلى آخره.
وفي أخرى في تفسير قوله :( ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَهِيَ دُخانٌ ) (٢) فكان ذلك الدخان من تنفّس الماء حين تنفّس، فجعلها سماء واحدة، ثمّ فتقها فجعلها سبع سماوات في يومين إلى آخره.
ويدلّ على أنّ السماوات سبع قوله تعالى أيضا :( ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) (٣) وقوله تعالى :( ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَهِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحى فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها ) (٤) إلى آخره.
وفي رواية مرويّة في «العلل» و «العيون» و «الخصال» : إنّ شاميّا سأل أمير المؤمنين عليه السلام فقال : ممّ خلق السماوات؟ قال : من بخار الماء.
__________________
(١) بحار الأنوار ٥٧ : ٢٠٤.
(٢) فصّلت : ١١.
(٣) البقرة : ٢٩.
(٤) فصّلت : ١١ و ١٢.
وسأله عن سماء الدنيا [من] ما هي؟ قال : من موج مكفوف.
وسأله كم طول الكوكب وعرضه؟ قال : إثنا عشر فرسخا في اثني عشر فرسخا.
وسأله عن ألوان السماوات السبع وأسمائها؟
فقال عليه السلام له : اسم السماء الدنيا «رقيع»(١) وهي من ماء ودخان، واسم السماء الثانية «قيدوم» وهي على لون النحاس، والسماء الثالثة اسمها «المأروم»(٢) وهي على لون الشبه، والسماء الرابعة اسمها «أرفلون»(٣) وهي على لون الفضّة، والسماء الخامسة اسمها «هيعون»(٤) وهي على لون الذهب، والسماء السادسة اسمها «عروس» وهي ياقوتة خضراء، والسماء السابعة اسمها «عجماء» وهي درّة بيضاء(٥) إلى آخره. انتهى.
وأمّا ما ذكره أرباب الهيئة من أنّ الأفلاك تسعة فهو مبنيّ على جعل الكرسيّ والعرش أيضا من الأفلاك. قالوا : إنّ العالم الجسمانيّ منضدة من ثلاث عشرة كرة أعلاها الفلك الأطلس، ويسمّى الفلك الأعظم، والفلك الأعلى، وفلك الأفلاك، ولا كوكب فيه، ولذا سمّي بالأطلس. وقيل : إنّه كاسمه غير مكوكب. ويقال له محدّد الجهات.
قال قطب الدين الشيرازيّ في كتابه المسمّى بـ «نهاية الإدراك في دراية
__________________
(١) في العلل : رفيع.
(٢) في العلل : المادون.
(٣) في الخصال : أرقلون.
(٤) في الخصال : هيفون.
(٥) علل الشرائع : ٥٩٣ ؛ والخصال : ٣٤٤ ؛ وبحار الأنوار ٥٨ : ٨٨.
الأفلاك» : إذ به وبمركزه وهي النقطة الّتي تتساوى جميع الخطوط المستقيمة الخارجة منها إلى ذلك السطح الّذي مركز العالم يحدّد جهتها العلوّ والسفل الطبيعتان تنقسم إلى بسيط ومركّب، والبسيط ما تتشابه أجزاؤه وطباعه ؛ أي لا تنقسم إلى أجسام مختلفة الصور والطبائع، بل له طبيعة واحدة يصدر عنها ما يصدر على نهج واحد، والمركّب ضدّه. والبسيط ينقسم إلى أثيريّ وعنصريّ، والأوّل هو الأفلاك وما فيها من الكواكب، وتسمّى الأثيريّات، والسماوات، والأجرام العلويّة، والعالم العلويّ، وعالم الأفلاك. والثاني هو العناصر الأربعة المشهورة المسمّى بالاستقصاءات بما فيها من المركّبات وتسمّى العنصريّات، والأرضيّات، والأجرام السفليّة، والعالم السفليّ، وعالم الكون والفساد. انتهى.
وكيف كان ففي تسمية هذا الفلك بالعرش أو الكرسيّ اختلاف يظهر من اختلاف الأخبار، ففي بعضها وهو رواية الفضيل في تفسير قوله تعالى :( وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ ) (١) أنّ السماوات والأرض وكلّ شيء في الكرسيّ(٢) .
وفي بعضها : إنّ كلّ شيء خلق الله في جوف الكرسيّ خلا عرشه، فإنّه أعظم من أن يحيط به الكرسيّ(٣) .
وفي بعضها : ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسيّ إلّا
__________________
(١) البقرة : ٢٥٥.
(٢) في الكافي ١ : ١٣٢ فقال عليه السلام : يا فضيل، كلّ شيء في الكرسيّ، السماوات والأرض، وكلّ شيء في الكرسيّ.
(٣) بحار الأنوار ١٠ : ١٨٨.
كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وإنّ فضل العرش على الكرسيّ كفضل الفلاة على تلك الحلقة(١) .
وبالجملة : الفلك الثامن سواء سمّي بالعرش أو الكرسيّ هو فلك الثوابت وفلك الروح، وهو تحت الفلك الأطلس، وهذه الكواكب الثابتة فيه مركوزة في شحنته وحجمه، وحركتها بطيئة كحركة فلكها، فترى كأنّها ثابتة بخلاف الكواكب السبعة السيّارة الّتي في كلّ فلك من الأفلاك السبعة الواقعة تحت فلك الثوابت واحد منها وكلّ فيها يسبحون. هذا مجمل من شرح الأفلاك التسعة على مذهب الحكماء وأهل الهيئة، ولعلّ تسميتهم العرش والكرسيّ فلكا لكونهما كرتان متحرّكتان حول العالم، فيصدق عليهما تعريف الفلك.
ولعلّ حصر الأفلاك في السبعة ـ كما هو ظاهر القرآن والأخبار ـ لما في كلّ واحد منها من الكواكب السيّارات. وأمّا كرة الماء والهواء والنار والأرض فهي واقعة تحت الفلك السابع المسمّى بفلك القمر، فمجموع العالم الجسمانيّ منضّد من الثلاث عشرة كرة. وأمّا العالم الروحانيّ، فلا يحيط بعلمه سوى الله. وقد قيل : إنّ العالم اسم كلّ ما وجوده ليس من ذاته، وهو منقسم إلى روحانيّ وجسمانيّ.
وقوله :( طِباقاً ) بكسر «الطاء» في التفسير الصادقي عليه السلام : بعضها طبق لبعض(٢) . انتهى ؛ أي مطابقة.
__________________
(١) بحار الأنوار ٥٨ : ١٧ منقولا عن الدرّ المنثور ؛ وفي معاني الأخبار : ٣٣٢.
(٢) تفسير القمّيّ ٢ : ٣٧٨.
فهو مصدر من مصادر المفاعلة ؛ نظير القتال والمقاتلة، يقال : طابقت النعل : إذا خصفتها طبقا على طبق، أي : أطبقت طاقا على طاق ؛ من الخصف، وهو ضمّ الشيء إلى الشيء، وإلصاقه به.
والمراد بالمطابقة ؛ إمّا كون واحدة من السماوات فوق الأخرى، وواحدة تحت الأخرى. وإمّا المشابهة ؛ أي يشبه بعضها بعضا في الإتقان والإحكام، والاتّساق والانتظام.
وعلى الوجهين ؛ فالوصف بالمصدر للمبالغة في المطابقة، كما في «زيد عدل» ويحتمل كونه حالا، نظرا إلى التخصيص بالإضافة، وإلّا فلا يجوز إتيان الحال عن النكرة المحضة.
قال الطبرسيّ : و «طباقا» نصب على الحال إذا أردنا في «سماوات» معنى «الألف واللام»(١) . انتهى.
والأوّل أولى لشيوع الوصف بالمصدر ؛ كما قال ابن مالك :
قد نعتوا بمصدر كثيرا |
فالتزموا الإفراد والتذكيرا(٢) |
وقد يرتكب في المقام حذف المضاف فتنتفي المبالغة، وقد يجعل «طباقا» جمع الطبق محرّكة، نظير الجبال في جمع الجبلي ؛ أي ذوات طبقات ؛ بعضها فوق بعض.
وقوله :( ما تَرى ) إلى آخره، خبر لقوله «الّذي» إن جعلناه مبتدأ والجملة المخبر بها وإن احتاجت إلى رابط يعود إلى المبتدأ إلّا أنّه قد يقوم
__________________
(١) مجمع البيان ١٠ : ٤٠٨.
(٢) البهجة المرضية ؛ (باب النعت).
مقام الضمير اسم الظاهر لنكتة.
والمراد بـ «خلق الرحمن» إمّا العموم بالنسبة إلى تمام مخلوقاته ؛ كما يقتضيه المصدر المضاف.
فالمراد بالتفاوت : العيب والاعوجاج وخلاف ما تقتضيه الحكمة والمصلحة، يعني أنّ أفعاله كلّها شرع سواء في الإتقان والإحكام، وإن اختلفت بحسب الصورة والهيئة :
پير ما گفت خطا در قلم صنع نرفت |
آفرين بر نظر پاك خطا پوشش باد |
وإمّا خصوص خلق السماوات، نظرا إلى تقدّم ذكر خلقها، وسوق الآية لذلك، فالإضافة للعهد، يعني أنّها متناسبة الأجزاء، مستقيمة الأجرام، صحيحة الانتظام والاتّساق على أحسن التراتيب، مع اشتمالها على كثير من الأعاجيب.
و «إرجاع البصر» ردّه وإدارته لمكان التحقيق في التفاوت وعدمه، لئلّا يقع الالتباس في الحسّ.
قوله :( هَلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ ) ؛ أي لو أرجعت البصر وتأمّلت بعين التحقيق لم تجد للسماوات فروجا وصدوعا وشقوقا، ومثله قوله :( وَما لَها مِنْ فُرُوجٍ ) (١) ؛ أي فتوق ؛ كسائر الأبنية المبنيّة من الأحجار واللبنات، بل هي ملساء متّصلة ليس فيها تفاوت واختلاف.
__________________
(١) ق : ٦.
وقريب منه قوله :( سَبْعاً شِداداً ) (١) وقوله :( وَجَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً ) (٢) .
وقد استدلّ بعضهم بهذه الآيات على أنّ السماوات لا تقبل الخرق والالتيام ؛ كما عليه الحكماء المتقدّمون. وفيه نظر، فإنّ الإخبار عن عدم شيء لا يكون إخبارا عن عدم إمكانه، مع أنّ جملة من الآيات صريحة في إمكان ذلك، بل وقوعه بعد ذلك ؛ مثل قوله :( وَإِذَا السَّماءُ فُرِجَتْ ) (٣) وقوله :( إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ ) (٤) وقوله :( فَهِيَ يَوْمَئِذٍ واهِيَةٌ ) (٥) وقوله :( فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّماءُ فَكانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهانِ ) (٦) وقوله :( يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِ ) (٧) وقوله :( يَوْمَ تَمُورُ السَّماءُ مَوْراً ) (٨) .
وقد يقال : إنّ عدم الفطور ينافي سكون الملائكة فيها، ونزولهم إلى الأرض، وعروجهم إليها.
والجواب : إنّ الملائكة أرواح لطيفة، وبذلك يدفع أيضا ما قيل من أنّ كونها طباقا يقتضي كون بعضها مطبقا على البعض متماسّة، وهذا ينافي ما ذكر من اختلاف الملائكة وذهابهم وإيابهم، وربّما يدفع بأنّ المراد كونها موازية.
__________________
(١) النبأ : ١٢.
(٢) الأنبياء : ٣٢.
(٣) المرسلات : ٩.
(٤) الإنفطار : ١.
(٥) الحاقّة : ١٦.
(٦) الرحمن : ٣٧.
(٧) الأنبياء : ١٠٤.
(٨) الطور : ٩.
وأمّا ما ورد من أنّ لكلّ سماء بابا وحجابا فهذه الأبواب غير مرئيّة [فلا] تدرك بالبصر.
والمراد بـ «كرّتين» ؛ أي رجعتين إدامة النظر لا التثنية ؛ أي ارجع النظر مرّة بعد مرّة ؛ إذ بالمرّتين لا ينقلب البصر خاسئا ؛ أي بعيدا عن نيل المراد، ذليلا صاغرا. وهذا نظير قولهم : سعديك ولبّيك، فإنّه يراد به أنّه كلّما دعوتني لأمر فأنا ذو إجابة وذو ثبات، لا أنّي أجيبك إجابتين خاصّة.
و «الحسير» الكالّ الكليل العاجز عن الوصول إلى المطلوب، وهو وجدان الفطور في السماوات.
قال الطبرسيّ رحمه الله : والتحقيق أنّ بصر هذا الناظر بعد الإعياء يرجع إليه بعيدا عن طلبته، خائبا عن بغيته(١) . انتهى.
فالمراد كمال المبالغة في عدم إمكان مشاهدة الفطور لمن يكرّر النظر لمشاهدته.
والمراد بالخطابات في هذه الآية، إمّا المخاطب المعيّن، وهو شخص الرسول صلّى الله عليه وآله بعينه ؛ كما هو ظاهر الخطاب، نظرا إلى أنّ أصل الخطاب أن يكون لمعيّن مطلقا واحدا كان أو كثيرا، فإنّه وضع لتوجيه الكلام إلى الحاضر.
وإمّا كلّ من هو قابل للخطاب على سبيل البدل، فإنّه قد يترك الخطاب مع المعيّن إلى غيره ليعمّ كلّ مخاطب ؛ كما في قوله تعالى :( وَلَوْ تَرى إِذِ
__________________
(١) مجمع البيان ١٠ : ٤٠٩.
الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ ) (١) فإنّه ـ على ما صرّح به التفتازانيّ ـ لا يريد بهذا الخطاب مخاطبا معيّنا قصدا إلى تفظيع حال المجرمين ؛ أي عظمت حالهم الفظيعة في الظهور، وبلغت النهاية في الانكشاف لأهل المحشر إلى حيث يمتنع خفاؤها، فلا تختصّ بها رؤية راء دون راء، فلا يختصّ به مخاطب دون مخاطب، بل كلّ من تتأتّى منه الرؤية، فلا يدخل في هذا الخطاب. ومثله قولهم : «فلان لئيم ؛ إن أكرمته أهانك، وإن أحسنت إليه أساء إليك» إذ لا يريدون بذلك مخاطبا معيّنا، بل يريدون إن أكرم إليه وأحسن إليه أهان وأساء.
وعلى هذا ففي الآية دلالة على أنّ هذه الرؤية غير متميّزة لأحد من الناظرين. وأمّا على الأوّل، فالدلالة على ذلك بالفحوى تعني أنّه إذا لم تتيسّر الرؤية المذكورة للنبيّ صلّى الله عليه وآله الّذي هو أشرف الخلق وأكملهم في البصر والبصيرة، فكيف لغيره؟ فافهم.
قال صاحب العرائس بعد ذكر هذه الآية : حارت الأبصار والبصائر عن إدراك مائيّة استواء أفعاله، لأنّها عاجزة عن اللحوق بجريان قدرته الواسعة فيها، فإذا كانت كذلك في إدراك خلقه، فكيف تشاهد جلال القدم والأبصار والبصائر والقلوب والأرواح والعقول فانية حسيرة في أوّل سطوة من سطوات عظمته، راجعة عنها خاسئة، ولا يبقى عليها من العلم والعرفان. انتهى.
وقد يقال : إنّ في الآية إشارة إلى أنّ فعل الله إذا كان منزّها عن العيب والنقص فذاته أشدّ امتناعا عن ذلك، تعالى عمّا يصفه الملحدون، وسبحان الله عمّا يصفون.
__________________
(١) السجدة : ١٢.
( وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَجَعَلْناها رُجُوماً لِلشَّياطِينِ وَأَعْتَدْنا لَهُمْ عَذابَ السَّعِيرِ ) هذا قسم بقرينة اللام الموطّئة الّتي يتلقّى بها القسم، وهذه الآية في معنى قوله تعالى( إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ ) (١) وقوله تعالى :( وَزَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَحِفْظاً ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ) (٢) .
والمراد بـ «السماء الدنيا» هو الفلك الأوّل الّذي هو أقرب الأفلاك إلى كرة الأرض، ويسمّى بفلك القمر، كما أنّ الثاني يسمّى بفلك عطارد، والثالث بفلك زهرة، والرابع بفلك الشمس، والخامس بفلك مرّيخ، والسادس بفلك المشتري، والسابع بفلك زحل.
والمراد بـ «المصابيح» ـ وهي لغة : السرج ـ : الكواكب، بعلاقة المشابهة في الإضاءة وقرينة الآية الأخرى، وقد تقدّم أنّ القرآن يكشف بعضه عن بعض.
وتنكير «المصابيح» للتعظيم وكثرة الاعتناء بشأنها ؛ كما في قول الشاعر :
له حاجب عن كلّ أمر يشينه
وقولهم : إنّ له لغنما.
و «الرجوم» جمع الرجم. والمراد به «الآلة» أي : ما يرجم به.
وقد يقال : إنّ المراد من «الشياطين» «المنجّمون» الّذين يحكمون بأوضاع الكواكب رجما بالغيب، وب «الرجوم» «ظنونهم». وهذا بعيد بعد
__________________
(١) الصافّات : ٦ و ٧.
(٢) فصّلت : ١٢.
ملاحظة قوله تعالى :( وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ ) (١) ونحوه. هذا مع ما ورد من الأخبار في مدح علم النجوم. فتأمّل.
وفي الآية دلالة على ما ذهب إليه بلنياس الحكيم من قدماء الحكماء من أنّ النجوم الثوابت في فلك القمر.
قال في كتاب «علل الأشياء» على ما حكى عنه المجلسيّ رحمه الله : هي سبعة أفلاك بعضها في جوف بعض، وصارت الأفلاك في كلّ منها كوكب غير فلك القمر، فإنّ الكواكب تبدّدت فيه وتقطّعت لاختلاطها بكثرة الرياح الصاعدة إليه من قرب الأرض(٢) . انتهى.
وعلى هذا فلا إشكال في الآية من هذه الجهة، ولكنّ أكثرهم، بل جميع أهل الهيئة ـ على ما قيل ـ على أنّه ليس في السماء الأولى سوى القمر، وسائر السيّارات كلّ في فلك، والثوابت كلّها في الفلك الثامن. وعلى هذا فيرد الإشكال على ظاهر الآية، لدلالتها على أنّ كلّها أو أكثرها في السماء الأولى.
والجواب عن ذلك من وجوه :
منها : أنّ تزيّن السماء الأولى وتحسّنها بالكواكب لا يستلزم كونها في داخلها، ولمّا كانت ترى وتشاهد فيها لمكان شفّافيّة الأفلاك، صحّ أن يقال : إنّها مزيّنة بسببها ؛ أي بسبب ظهورها وانعكاسها فيها، نظير السراج المرئيّ خلف الزجاج، واختصاص هذه السماء بالتزيّن لمكان كونها مرئيّة للناس بقربها منهم.
__________________
(١) الصافّات : ٧.
(٢) بحار الأنوار ٥٨ : ٧٨.
ومنها : أنّ الناظر إلى هذه السماء لمـــّـا كان يتخيّل أنّ الكواكب فيها، جرت الآية على ما يتخيّله الناس. فتأمّل.
ومنها : أنّه لا يبعد وجود كرة تحت كرة القمر، فتكون في البطء مساوية لكرة الثوابت. حكي عن الرازيّ. وفيه نظر.
ومنها : أنّه يجوز أن تكون جميع الأفلاك الثمانية الّتي أثبتوها لجميع الكواكب فلكا واحدا مسمّى بالسماء الدنيا، وتكون غيرها ستّة سماوات أخر غير مكوكبة ؛ كما أنّهم يثبتون لكلّ من الكواكب أفلاكا كثيرة جزئيّة، ويعدّون الكلّ فلكا واحدا كلّيّا. قاله المجلسيّ رحمه الله(١) . وفيه أيضا ما لا يخفى. فليتأمّل.
ومنها : أنّ المراد بالكواكب المزيّنة للسماء هي الشهب المنقضّة من الكواكب، ولمّا كانت ترى حسّا على سطح السماء فهي زينة لها ؛ كما يؤيّده قوله :( وَجَعَلْناها رُجُوماً ) (٢) فإنّ الشهب يرجم بها لا الكواكب ؛ كما ستعرفه.
ومنها : أنّ المراد بالدنيا المدنو من الناحية العليا والعرش الأعلى، فالمراد بها الفلك الثامن.
وفي الآية إشكال آخر، وهو أنّ الكواكب مركوزة في ثخن الفلك، فلا يمكن انتقالها من محالّها، فكيف يرجم بها الشياطين؟ ودفع بأنّهم لا يرجمون بالكواكب أنفسها، لأنّها قارّة في الفلك على حالها، ولكن ينفصل من نار الكواكب شهاب كقبس يؤخذ من نار، والنار ثابتة كاملة لا تنقص،
__________________
(١) بحار الأنوار ٥٨ : ٧٨.
(٢) الملك : ٥.
فيرجمون بالشهب الّتي تنقضّ لرمي الشياطين المسترقين للسمع، وهي منفصلة من نار الكواكب ؛ كما قال :( وَحَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ * إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ مُبِينٌ ) (١) .
وعن ابن عبّاس : إنّه كان في الجاهليّة كهنة ومع كلّ واحد شيطان، فكان يقعد [من السماء مقاعد] للسمع، فيستمع من الملائكة ما هو كائن في الأرض، فينزل ويخبر به الكاهن، فيفشيه الكاهن إلى الناس، فلمّا بعث الله عيسى عليه السلام منعوا من ثلاث سماوات، ولمّا بعث محمّدا صلّى الله عليه وآله منعوا من السماوات كلّها، وحرست السماء بالنجوم، والشهاب من معجزات نبيّنا صلّى الله عليه وآله(٢) .
وقيل : الشهاب عمود من نور يضيء ضياء النار لشدّة ضيائه.
وقيل : شعلة نار تظهر لأهل الأرض.
وهل يقتل الشياطين المسترقون للسمع بهذه الشهب ويحرقون بها أو لا يقتلون؟ قولان، ويمكن أن يقال : إنّ لهم عذابين : عذاب في الدنيا ؛ وهو الرجم بالشّهب، وعذاب في الآخرة ؛ كما قال :( وَأَعْتَدْنا لَهُمْ ) (٣) ؛ أي هيّأنا لهم،( عَذابَ السَّعِيرِ ) ؛ أي جهنّم.
قيل : وفيه دلالة على أنّهم مكلّفون.
ويحتمل أن يراد بـ «السماء الدنيا» : قلب المؤمن السليم عن الصفات
__________________
(١) الحجر : ١٧ و ١٨.
(٢) بحار الأنوار ٥٨ : ٦٨.
(٣) الملك : ٥.
الرذيلة، فإنّه أقرب إليه من كلّ عضو، وبالكواكب والمصابيح : أخلاقه الحميدة المستضيئة بأنوار المعرفة الإلهيّة، وبالشياطين : الملكات النفسانيّة الخبيثة، والأخلاق الرذيلة الشيطانيّة ؛ أعاذنا الله منها.
( وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ) و «اللام» للاستحقاق، فإنّ العذاب من نتائج الكفر، وثمرات شجرته الخبيثة، بل هو عينه المنقلبة إليه المتصوّرة في القيامة بهذه الصورة على القول بتجسّم الأعمال والعقائد ؛ كما يرشد إليه ظاهر جملة من الآيات وصريح بعض الروايات ؛ مثل قوله : إنّما هي أعمالكم تردّ إليكم(١) .
وعموم الآية بمقتضى صيغة الجمع وحذف المتعلّق يشمل الشياطين والإنس وإن احتمل الاختصاص بالفرقة الأولى بحسب السياق، ويحتمل الاستخدام في الآية السابقة بإرادة التعميم من «لهم» بإرجاع الضمير إلى مطلق الشياطين، وإن لم يسترقوا السمع وإرادة شياطين الإنس والجنّ من مطلقهم، فافهم.
ويحتمل «اللام» للاختصاص ؛ كما يرشد إليه تقديم الخبر المشعر بالحصر، ولكن يرد عليه ثبوت العذاب للمجرمين، ولو في الجملة أيضا، وإن لم يكونوا كفّارا ؛ كما دلّت عليه الآيات والروايات والضرورة من الدين والمذهب.
ويمكن دفعه بتعميم الكفر للمعاصي، لقوله عليه السلام : لا يزني الزاني وهو مؤمن(٢) ونحوه، أو تخصيص العذاب بالدائم الأبديّ على القول
__________________
(١) بحار الأنوار ٣ : ٩٠.
(٢) الكافي ٢ : ٢٨٨.
به ؛ كما هو الحقّ المحقّق عند أهل الحقّ، لظاهر الآيات والأخبار المتواترات، خلافا لمن حمل الخلود على المكث الطويل، لرواية موضوعة : سيأتي زمان على جهنّم ينبت في قعرها الجرجير(١) .(٢)
وقد يقال : إنّ الآية الأولى مخصوصة بالشياطين المسترقين، وهذه الآية بسائر الكفّار. ويؤيّده قراءة «عذاب جهنّم» بالنصب على كونه معطوفا على «عذاب السعير» ؛ أي وأعتدنا للّذين كفروا عذاب جهنّم، فيكون المراد بـ «السعير» طبقة خاصّة من طبقات جهنّم، فإنّ لكلّ طبقة منها اسما خاصّا وعذابا مخصوصا ؛ كما يستفاد من بعض الروايات والمخصوص بالذّم محذوف وهو «هو» إن رجع إلى المضاف أو «هي» إن رجع إلى المضاف إليه، وكذا إن رجع إلى المضاف بناء على الإكساب ؛ كما في قوله :
كما شرقت صدر القناة من الدم(٣)
والأولى تقدير الاسم الظاهر من المضاف أو المضاف إليه، فلا حاجة إلى تجشّم ما ذكرناه. فتأمّل.
قال شيخنا الطبرسي رحمه الله : وإنّما وصف بـ «بئس» وهو من صفات الذمّ والعقاب حسن، لما في ذلك من الضرر الّذي يجب على كلّ عاقل أن يتّقيه بغاية الجهد، ولا يجوز قياسا على ذلك أن يوصف به فاعل العقاب، لأنّه لا يقال «بئس الرجل» إلّا على وجه الذمّ، ووجه الحكمة في [فعل]
__________________
(١) الجرجر والجرجير : بقلة معروفة.
(٢) إشارة إلى أحاديث منها ما في البحار ٦٦ : ٢٣٦ ؛ وفي مقابلها ما في البحار ٨ : ٣٠٦ و ٦٦ : ٢٣٧.
(٣) جامع الشواهد ٣ : ١٣٣. والبيت من قصيدة للأعشى، وصدره : وتشرق بالقول الّذي قد أذعته.
العقاب ما فيه من الزجر المتقدّم للمكلّف، ولا يمكن أن يكون مزجورا إلّا به، ولولاه لكان مغريا بالقبيح(١) . انتهى.
ولا يخفى أنّ الله كما هو خالق الخير خالق للشرّ أيضا، وخلق الشرّ لمصلحة وحكمة ليس بقبيح، وكون الشرّ من حيث هو شرّ لا ينافي حسنه من جهة أخرى ؛ كالزجر، ومكافاة المسيء والظالم، فالذمّ في قوله :( وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ) راجع إلى نفس جهنّم الّتي هي مرجع الكافر ومآله لا إلى فاعل العقاب.
وقوله تعالى :( إِذا أُلْقُوا فِيها سَمِعُوا لَها شَهِيقاً وَهِيَ تَفُورُ * تَكادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ) بيان لشدّة العذاب والتهاب النار عليهم.
و «الإلقاء» الطرح، يقال : ألقيت الحطب على النار : إذا طرحته ورميته فيها، ومنه قوله :( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) (٢) ؛ أي تطرحوها.
( سَمِعُوا لَها ) ؛ أي لجهنّم ونارها المسعرة فيها تشبيها لحسيسها المنكر الفظيع بالشهيق وهو صوت تقطيع النّفس، أو صوت في الصدر، كما أنّ الزفير صوت في الحلق.
وقد يقال : إنّ المراد شهيق أهل النار لقوله :( لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ) (٣) .
و( تَفُورُ ) من الفور، وهو ارتفاع الشيء بالغليان ؛ أي تغلي بهم غليان المرجل بما فيه.
__________________
(١) مجمع البيان ١٠ : ٤١٠.
(٢) البقرة : ١٩٥.
(٣) هود : ١٠٦.
( تَمَيَّزُ ) كتنزّل ؛ أي تتفرّق، شبّهت بالغضبان المغتاظ إذا اشتدّ غضبه وخرج عن حالته الطبيعيّة، كأنّه طارت منه شقّة في الأرض وشقّة في السماء لغاية اضطرابه وقلقه.
وفي الكشّاف : ويجوز أن يراد : غيظ الزبانية(١) . انتهى.
أي التسعة عشر من الملائكة الموكّلين بجهنّم ؛ الغلاظ الشداد، الّذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
وعلى القول بأنّ الأشياء كلّها شاعرة ناطقة فنسبة التغيّظ إلى جهنّم حقيقيّة كنسبة التسبيح إليها. فتأمّل.
( كُلَّما أُلْقِيَ فِيها فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ * قالُوا بَلى قَدْ جاءَنا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنا وَقُلْنا ما نَزَّلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلالٍ كَبِيرٍ ) وكلمة «كلّما» في هذه الآية ونظائرها ؛ كقوله :( كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها ) (٢) وقوله :( كُلَّما رُزِقُوا مِنْها مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قالُوا ) (٣) وقوله :( كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها ) (٤) وقوله :( كُلَّما دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ ) (٥) وقوله :( كُلَّما مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ) (٦) وقوله :( كُلَّما جاءَهُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى أَنْفُسُهُمْ ) (٧) إلى آخره. وقول الشاعر :
__________________
(١) الكشّاف ٤ : ٥٧٨.
(٢) الأعراف : ٣٨.
(٣) البقرة : ٢٥.
(٤) النساء : ٥٦.
(٥) نوح : ٧.
(٦) هود : ٣٨.
(٧) المائدة : ٧٠.
وقولي كلّما جشأت وجاشت |
مكانك تحمدي أو تستريحي |
منصوبة على الظرفيّة مفيدة للشرطيّة، وناصبها الفعل الّذي هو جواب في المعنى، وهو في الآية( سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها ) (١) .
قال ابن هشام في المغني : وجاءتها الظرفيّة من جهة «ما» فإنّها محتملة لوجهين :
أحدهما : أن تكون حرفا مصدريّا والجملة بعده صلة له، فلا محلّ لها، والأصل كلّ وقت رزق، ثمّ عبّر عن معنى المصدر بـ «ما» والفعل، ثمّ أنيبا عن الزمان ؛ أي كلّ وقت رزق كما أنيب عنه المصدر الصريح في «جئتك خفوق الثريّا».
والثاني : أن تكون اسما نكرة بمعنى وقت، فلا يحتاج على هذا إلى تقدير [وقت، والجملة بعده في موضع خفض على الصفة، فتحتاج إلى تقدير] عائد منها ؛ أي كلّ وقت رزقوا فيه إلى آخر ما ذكره(٢) . انتهى.
و «الفوج» الجماعة، أو الجماعات المختلفة.
والمراد بـ «الخزنة» من أشرنا إليه من التسعة عشر ؛ كما قال :( عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ ) (٣) وهذه الآية من الآيات الدالّة على اختصاص العذاب بالكفّار، فإنّها صريحة في أنّ الملقون في النار هم المكذّبون المنكرون لتنزيل الله شيئا، وهم الكفّار.
__________________
(١) الملك : ٨.
(٢) مغني اللبيب (الباب الأوّل) حرف الكاف، كلمة «كلّ».
(٣) المدّثّر : ٣٠.
ويقرب من هذه الآية قوله تعالى في سورة المؤمن :( وَقالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِنَ الْعَذابِ * قالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا بَلى قالُوا فَادْعُوا وَما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلالٍ ) (١) ويدلّ عليه أيضا قوله :( لا يَصْلاها إِلَّا الْأَشْقَى * الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ) (٢) وقوله :( وَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ * فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ * وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ) (٣) وقوله :( رَبَّنا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ) (٤) .
قيل : فلمّا لم يحصل الخزي إلّا للكفّار لزم أن لا يدخل النار إلّا الكفّار.
وقوله حكاية عن موسى عليه السلام :( إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنا أَنَّ الْعَذابَ عَلى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ) (٥) .
ويظهر من هذه الآيات ضعف القول بخلود أصحاب الكبائر في النار ؛ كما يزعمه الوعيديّة من المعتزلة، لقوله تعالى :( بَلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ ) (٦) وقوله :( وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها ) (٧) وقوله :( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها ) (٨) فإنّ كلمة «من» تفيد العموم. وقوله :
__________________
(١) غافر : ٤٩ ـ ٥٠.
(٢) الليل : ١٥ و ١٦.
(٣) الواقعة : ٩٢ ـ ٩٤.
(٤) آل عمران : ١٩٢.
(٥) طه : ٤٨.
(٦) البقرة : ٨١.
(٧) النساء : ١٤.
(٨) النساء : ٩٣.
( وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ * يَصْلَوْنَها يَوْمَ الدِّينِ * وَما هُمْ عَنْها بِغائِبِينَ ) (١) فإنّ الجمع المحلّى بـ «اللام» مفيد للعموم، فلو أخرجوا من النار لكانوا غائبين عنها.
والجواب عن الجميع : أنّ العامّ يخصّص، ومقتضى الجمع والتوفيق اختصاص الخلود بالكفّار المكذّبين.
لا يقال : إنّ مبغضي عليّ بن أبي طالب عليه السلام ليسوا بالمكذّبين، فلا وجه للقول بخلودهم في النار.
فإنّ الأخبار المتواترة في هذا الباب قد دلّت على التخصيص ؛ كما أنّ الأخبار الدالّة على أنّ أمّة محمّد صلّى الله عليه وآله لا يخلّدون في النار، وأنّهم مغفور لهم بالشفاعة الكبرى مخصّصة أيضا، مع أنّ المراد بـ «الأمّة» : الأمّة الإجابتيّة دون الدعوتيّة، فالمبغضون لعليّ عليه السلام خارجون عنهم، لإنكارهم وتكذيبهم الرسول فيما بلّغه من ولاية عليّ عليه السلام.
وفي بعض الروايات دلالة على أنّ المخالف إذا لم يكن في قلبه شيء من بغضه لا يخلّد في النار، بل يدخل الجنّة. فليتأمّل.
وروى معاذ عن رسول الله صلّى الله عليه وآله أنّه قال : يحشر [عشرة] أصناف من أمّتي أشتاتا ؛ قد ميّزهم الله تعالى من المسلمين، وبدّل صورهم، فبعضهم على صورة القردة، وبعضهم على صورة الخنازير، وبعضهم منكّسون أرجلهم من فوق ووجوههم من تحت يسحبون عليها، وبعضهم عمي، وبعضهم بكم، وبعضهم يمضغون ألسنتهم فهي مدلّاة على صدورهم ؛ يسيل القيح من أفواههم، وبعضهم مقطّعة أيديهم وأرجلهم،
__________________
(١) الانفطار : ١٤ ـ ١٦.
وبعضهم مصلّبون على جذوع من نار، وبعضهم أشدّ نتنا من الجيف، وبعضهم ملبّسون ثيابا سابغة من قطران، لازقة بجلودهم.
فأمّا الّذين على صورة القردة فالقتّات من الناس.
وأمّا الّذين على صورة الخنازير فأهل السحت.
وأمّا المنكّسون على رؤوسهم فآكلة الربا.
وأمّا العمي فالّذين يجورون في الحكم.
وأمّا الصمّ البكم فالمعجبون بأعمالهم.
وأمّا الّذين يمضغون ألسنتهم فالعلماء والقضاة الّذين خالفت أعمالهم أقوالهم.
وأمّا الّذين قطّعت أيديهم وأرجلهم فهم الّذين يؤذون الجيران.
وأمّا المصلّبون على جذوع من النار فالسعاة بالناس إلى السلطان.
وأمّا الّذين هم أشدّ الناس نتنا من الجيف فالّذين يتّبعون الشهوات واللذّات، ويمنعون حقّ الله في أموالهم.
وأمّا الّذين يلبّسون الجباب فأهل الكبر والفخر والخيلاء(١) . انتهى.
والظاهر أنّ المراد بالأمّة في هذا الحديث الأمّة الادّعائيّة ؛ كما يكشف عنه قوله صلّى الله عليه وآله في حديث آخر : عشرة يدّعون أنّهم من أمّتي وليسوا من أمّتي وأنا منهم بريء إلى آخره. ويمكن حمل الحديث على
__________________
(١) جاء هذا الحديث في : البحار ٧ : ٨٩ مع اختلاف شاسع، وهكذا في : جامع الأخبار : ١٧٦ في فصل الأربعون والمائة في الموقف.
المنافقين، بقرينة قوله : قد ميّزهم الله من المسلمين(١) . وهذا راجع إلى ما سبق أيضا. فتأمّل.
وفي قولهم :( بَلى ) في جواب قول الخزنة تصديق بإتيان النذير، واعتراف به ؛ كما صرّحوا به في قولهم :( قَدْ جاءَنا نَذِيرٌ ) (٢) فإنّ الهمزة ليست للاستفهام الحقيقيّ، بل هي للإنكار الإبطاليّ، فيقتضي أنّ ما بعدها خبر واقع، وأنّ مدّعيه كاذب ؛ كما في قوله :( أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ) (٣) وقوله :( أَفَأَصْفاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِناثاً ) (٤) إلى آخره. فيلزم ثبوته إن كان منفيّا، فإنّ هذه الهمزة مفيدة للنفي، ونفي النفي إثبات، وكلمة «بلى» مختصّة بالنفي، فتفيد إبطال ما ولي الهمزة ؛ كما في قوله :( زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلى وَرَبِّي ) (٥) وقوله :( أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ * بَلى ) (٦) إلى آخره.
وربّما يعبّر عن هذه الهمزة بالاستفهام التقريريّ ؛ بناء على أنّه تقرير بما بعد النفي لا بالمنفي، ولا مشاحّة فيه، وإن كان تعبير الأكثر أجدر.
والظاهر أنّ قوله :( إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلالٍ كَبِيرٍ ) (٧) حكاية عن قول الكفّار في جواب الخزنة، ففيه دلالة على أنّهم كانوا يعتقدون في الدنيا أنّهم على
__________________
(١) بحار الأنوار ٧ : ٨٩.
(٢) الملك : ٩.
(٣) الأعراف : ١٧٢.
(٤) الإسراء : ٤٠.
(٥) التغابن : ٧.
(٦) القيامة : ٣ ـ ٤.
(٧) الملك : ٩.
الحقّ والهدى، وأنّ الرسل على الضلالة في دعواهم الرسالة من جانب الله ؛ كما يرشد إليه قوله ـ حكاية عن قوم صالح عليه السلام ـ :( أَبَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذاً لَفِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ ) (١) وقوله ـ حكاية عن أهل أنطاكية ـ :( ما أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا وَما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ) (٢) .
وقيل : إنّه من كلام الخزنة للكفّار على تقدير القول، أي : فيقول لهم مالك وأعوانه ـ بعد قول الكفّار : بلى قد جاءنا ـ : إن أنتم إلّا في ضلال كبير، أي : إلّا في عذاب أليم شديد ؛ كما في الصادقي عليه السلام.
فالمراد بـ «الضلال» الهلاك، أو عقابه، بتقدير المضاف.
وقيل : إنّه من كلام الرسل لهم حكوه للخزنة ؛ أي قالوا لنا هذا فلم نقبله.
( وَقالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَّا فِي أَصْحابِ السَّعِيرِ ) ومفهومه : إنّا لم نسمع، ولم نعقل، فكنّا من أصحاب السعير، فإنّ كلمة «لو» لامتناع الجواب بامتناع الشرط ؛ كما عليه أكثر النحاة، أو العكس ؛ كما عليه ابن الحاجب.
فإنّ الأوّل سبب، والمسبّب قد يكون أعمّ من السبب ؛ كالإشراق الحاصل من النار والشمس. قال : فالأولى أن يقال : انتفاء الأوّل لانتفاء الثاني، لأنّ انتفاء المسبّب يدلّ على انتفاء كلّ سبب. وعلى ما ذكره، ففي الآية دلالة على أنّ السبب لعدم السماع، والعقل هو القضاء الأزليّ بالشقاوة الداعية إلى كونهم من أصحاب السعير ؛ كما يشير إليه قوله :( أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ
__________________
(١) القمر : ٢٤.
(٢) يس : ١٥.
فِي النَّارِ ) (١) فيرجع الكلام إلى مسألة القضاء والقدر المنهيّ عن الكلام فيها، وينافي بظاهره اعترافهم بالذنب، فإنّهم يستندون في الصادر عنهم إلى علم الله، ويزعمون أنّه علّة وسبب له ؛ كما يومي إليه قوله :( وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا ) (٢) .
قال المحقّق النراقيّ رحمه الله في «مشكلات العلوم» : فالفقرة الأولى لفظة «لو» فيها على أصلها ؛ أي انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط، وأمّا الثانية فالظاهر أنّها من قبيل لو لم يخف الله لم يعصه، فيجب أن يوجّه بما وجّه به إلى آخر ما ذكره، وهو طويل. فتأمّل ولا تغفل.
وكيف كان، فلهم في تفسير الآية وجوه :
منها : ما ذكره صاحب الحقائق من أنّ المعنى : لو سمعنا الخطاب الأزليّ شفاها في مشاهداته، وعلمنا حقيقته، ما كنّا من أصحاب البعد والحجاب.
ومنها : ما حكاه عن بعضهم من أنّ المعنى : لو سمعنا موعظة الواعظين، وعقلنا نصيحة الناصحين لاتّبعناهم فيما أمروا به، ولما كنّا إذا في أصحاب السعير.
ومنها : ما حكي عن الزجّاج من أنّ المعنى : لو كنّا نستمع سمع من يعي ويفكّر، و [نعقل] عقل من يميّز وينظر، ما كنّا من أهل النار(٣) .
ومنها : ما يستفاد من التفسير الصادقيّ عليه السلام أنّ المراد : لو كنّا نطيع
__________________
(١) الزمر : ١٩.
(٢) الأنفال : ٢٣.
(٣) مجمع البيان ١٠ : ٤١٠.
أو نقبل ما أمرنا به ما كنّا من أصحاب السعير. قال عليه السلام : قد سمعوا وعقلوا ولكنّهم لم يطيعوا ولم يقبلوا، والدليل على أنّهم قد سمعوا وعقلوا ولم يقبلوا قوله :( فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ ) (١) (٢) إلى آخره. انتهى.
يعني أنّه إذا كانوا لم يسمعوا ولم يعقلوا فلا يثبت لهم تكليف حتّى يترتّب عليه الذنب، فإنّ ذلك من شرائط حسن التكليف ؛ كما حقّق في محلّه. ففي الاعتراف بالذنب وتقريره دلالة على تحقّق السمع والعقل، ويرشد إليه قوله تعالى :( وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ) (٣) .
ومنها : أنّ المراد : لو كنّا نعتقد ما اقتضته الأدلّة السمعيّة من الكتاب والسنّة، وأدّت إليه الأدلّة العقليّة، ما كنّا من أصحاب النار.
قال في الكشّاف : إنّما جمع بين السمع والعقل، لأنّ مدار التكليف على [أدلّة] السمع والعقل(٤) .
ومنها : إنّ المراد : أنّا لو كنّا ننقاد لأولياء الأمر، وكنّا في تقليد صحيح، أو ندرك بعقولنا، ونميّز الحقّ من الباطل، وكنّا محقّقين.
ومنها : ما روي من أنّ هذه الآيات نزلت في أعداء أمير المؤمنين عليه السلام، فالمعنى : لو كنّا نسمع أو نعقل ما ورد في حقّ عليّ عليه السلام وولايته ما كنّا مخلّدين في النار.
ومنها : ما ذكره في الصافي من : أنّا لو كنّا نسمع كلام الرسل فنقبله جملة
__________________
(١) الملك : ١١.
(٢) تفسير القمّيّ ٢ : ٣٧٨.
(٣) الإسراء : ١٥.
(٤) الكشّاف ٤ : ٥٧٩.
من غير بحث وتفتيش اعتمادا على صدقهم، أو نعقل فنفكّر في حكمه ومعانيه تفكّر المستبصرين، ما كنّا في عداد أصحاب الجحيم وفي جملتهم(١) .
ومنها : ما ذكره في الكشّاف من : أنّا لو كنّا نسمع الإنذار سماع طالبين للحقّ، أو نعقله عقل متأمّلين(٢) .
ولا يخفى أنّه يمكن إرجاع بعض هذه الوجوه إلى بعض آخر.
وفي الكشّاف : إنّ من بدع التفاسير أنّ المراد لو كنّا على مذهب أهل(٣) الحديث أو على مذهب أصحاب الرأي ؛ كأنّ هذه الآية نزلت بعد ظهور هذين المذهبين، وكأنّ سائر أصحاب المذاهب والمجتهدين قد أنزل الله وعيدهم، وكأنّ من كان من هؤلاء فهو من الناجين لا محالة(٤) إلى آخره. انتهى.
هذا مع أنّه لو صحّ هذا التفسير صحّ استدلال كلّ أهل مذهب بهذه الآية على صحّة مذهبه، وهو كما ترى.
وكيف كان، فهذه الآية جارية في الأصول والفروع، ودالّة على أنّ تارك طريقي الاجتهاد والتقليد لمن ليس له قوّة الاجتهاد مؤاخذ. فتأمّل.
( فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحابِ السَّعِيرِ ) قد عرفت اختصاص مورد ما تقدّم بالمقصّرين، وعدم شموله للقاصرين الّذين لم يبلغهم خطاب التكليف، فالأعتراف بالذنب في محلّه، ولكنّه غير نافع في الآخرة مطلقا،
__________________
(١) التفسير الصافي ٥ : ٢٠٢.
(٢) الكشّاف ٤ : ٥٧٨ ـ ٥٧٩.
(٣) في المصدر : أصحاب.
(٤) الكشّاف ٤ : ٥٧٩.
سواء كان من جهة الكفر، أو غيره من أصناف المعاصي، فإنّ المصدر المضاف مفيد للعموم، إلّا أنّ الظاهر أنّ الإضافة للعهد الذكريّ، فإنّ المعهود المذكور هو الكفر وتكذيب الرسل.
قال الطبرسيّ رحمه الله : و «الإقرار» مشتقّ من قرّ الشيء يقرّ قرارا : إذا ثبت. و «الاعتراف» مأخوذ من المعرفة. و «الذنب» مصدر لا يثنّى ولا يجمع، ومتى جمع فلاختلاف جنسه(١) . انتهى، فتأمّل.
وقال أيضا : وإذا قيل : ما وجه اعترافهم بالذنب مع ما عليهم من الفضيحة به؟
فالجواب : أنّهم قد علموا حصولهم على الفضيحة ؛ اعترفوا أم لم يعترفوا، فليس يدعوهم إلى أحد الأمرين إلّا مثل ما يدعوهم إلى الآخر في أنّه لا فرج فيه، فاستوى الأمران عليهم : الاعتراف وترك الاعتراف، والجزع وترك الجزع(٢) . انتهى، فتأمّل.
و «السحق» البعد عن الرحمة، ونصب «سحقا» على المصدر، وقد أنيب عن فعله المحذوف وجوبا ؛ كما في نظائره.
وقيل : أي ألزمهم الله سحقا، فجاء المصدر على غير لفظه، والظاهر أنّ الجملة دعائيّة، ويحتمل الخبريّة، وفائدتها الإخبار عن حالهم في الآخرة، وأنّ اعترافهم وترك اعترافهم سيّان في هذا اليوم، وإن كان الاعتراف بالذنب
__________________
(١) مجمع البيان ١٠ : ٤١١.
(٢) مجمع البيان ١٠ : ٤١١.
في الدنيا توبة، وقد قال الله :( فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا ) (١) وقال ـ حكاية عن قول جبرئيل لفرعون ـ :( آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ) (٢) .
( إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ) الخشية هي الخوف المفسّر بتألّم القلب واحتراقه بسبب توقّع مكروه في الاستقبال ؛ كما صرّح به الغزاليّ في الإحياء.
وعن المحقّق الطوسيّ رحمه الله إنّه بعد ما صرّح باتّحادهما معنى في اللغة قال : إلّا أنّ بين خوف الله وخشيته في عرف أرباب القلوب فرقا، وهو أنّ الخوف تألّم النفس من العقاب المتوقّع بسبب ارتكاب المنهيّات، والتقصير في الطاعات، وهو يحصل لأكثر الخلق ؛ وإن كانت مراتبه متفاوتة جدّا، والمرتبة العليا منه لا تحصل إلّا للقليل.
والخشية حالة تحصل عند الشعور بعظمة الحقّ وهيبته، وخوف الحجب عنه. وهذه حالة لا تحصل إلّا لمن اطّلع على حال الكبرياء، وذاق لذّة القرب، ولذا قال سبحانه :( إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ ) (٣) فالخشية خوف خاصّ، وقد يطلقون عليها الخوف. انتهى.
وفي فروق اللغات للسيّد نور الدين الجزائريّ بعد نقل ما ذكر : ويؤيّد هذا الفرق أيضا قوله يصف المؤمنين :( يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ ) (٤) حيث ذكر الخشية في جانبه والخوف في العذاب. انتهى.
__________________
(١) غافر : ٨٤.
(٢) يونس : ٩١.
(٣) فاطر : ٢٨.
(٤) الرعد : ٢١.
وكيف كان، فالخشية من ثمرات اليقين.
وفي مصباح الشريعة : قال الصادق عليه السلام : اليقين يوصل العبد إلى كلّ حال سنيّ، ومقام عجيب، كذلك أخبر رسول الله صلّى الله عليه وآله عن عظم شأن اليقين ؛ حين ذكر عنده أنّ عيسى ابن مريم عليه السلام كان يمشي على الماء، فقال : لو زاد يقينه لمشى على الهواء.
فدلّ بهذا على أنّ الأنبياء مع جلالة محلّهم من الله [كانت] تتفاضل على حقيقة اليقين لا غير، ولا نهاية بزيادة اليقين على الأبد، والمؤمنون أيضا متفاوتون في قوّة اليقين وضعفه، فمن قوي منهم يقينه فعلامته التبرّي من الحول والقوّة إلّا بالله، والاستقامة على أمر الله، وعبادته ظاهرا وباطنا ؛ قد استوت عنده [حالتا] العدم والوجود، والزيادة والنقصان، والمدح والذمّ، والعزّ والذلّ، لأنّه يرى كلّها من عين واحد، [و] من ضعف يقينه تعلّق بالأسباب، ورخّص لنفسه بذلك، واتّبع العادات، وأقاويل الناس بغير حقيقة، والسعي في أمور(١) الدنيا وجمعها وإمساكها، مقرّا باللسان أنّه لا مانع ولا معطي إلّا الله، وأنّ العبد لا يصيب إلّا ما رزق وقسم [له]، والجهد لا يزيد في الرزق، وينكر ذلك بفعله وقلبه(٢) إلى آخره. انتهى.
وفيه أيضا : قال الصادق عليه السلام : الخوف رقيب القلب، والرجاء شفيع النفس، ومن كان بالله عارفا كان من الله خائفا، وإليه راجيا، وهما جناحا الإيمان ؛ يطير بهما العبد المحقّق إلى رضوان الله، وعينا عقله يبصر
__________________
(١) في المصدر : أمر.
(٢) مصباح الشريعة : ١٧٧.
بهما [إلى] وعد الله ووعيده، والخوف طالع عدل الله باتّقاء وعيده، والرجاء داعي فضل الله وهو يحيى القلب، و [الخوف] يميت النفس. قال النبيّ صلّى الله عليه وآله : المؤمن بين خوفين : خوف ما مضى، وخوف ما بقي(١) إلى آخره. انتهى.
قوله :( بِالْغَيْبِ ) في محلّ النصب على الحاليّة من «الّذين» أو «من ربّهم».
قال الطبرسيّ : أي يخافون عذاب ربّهم باتّقاء معاصيه، وفعل طاعاته ؛ على وجه الاستسرار بذلك، لأنّ الخشية متى كانت بالغيب على ما ذكرناه(٢) كانت بعيدة من الرياء، خالصة لوجه الله، وخشية الله بالغيب تنفع بأن يستحقّ عليها الثواب، وخشيته في الظاهر بترك المعاصي لا يستحقّ بها الثواب، فإذا الخشية بالغيب أفضل لا محالة.
وقيل : بالغيب معناه أنّهم(٣) يخشونه ولم يروه فيؤمنون به خوفا من عذابه.
وقيل : يخافونه حيث لا يراهم مخلوق، لأنّ أكثر ما ترتكب المعاصي إنّما ترتكب في حال الخلوة، فهم يتركون المعصية لئلّا يجعلوا الله [سبحانه] أهون الناظرين إليهم، ولأنّ من تركها في هذه الحال تركها في حال العلانية(٤) . انتهى.
__________________
(١) مصباح الشريعة : ١٨٠.
(٢) في المصدر : ذكرنا.
(٣) في المصدر : أنّه.
(٤) مجمع البيان ١٠ : ٤١٣.
وفي تفسير الحقائق بعد ذكر هذه الآية : وصف الله تعالى معرفة العارفين به قبل رؤيتهم مشاهدته تعالى، فإذا عاينوه استفادوا من رؤيته علم المعاينة وهو المعرفة الحقيقيّة خشوا منه في غيبة منه، وهو خشية القلب، فلمّا رأوه زاد على الخشية نصيب القلب والسرّ والخوف نصيب البدن. انتهى.
وفيه ما لا يخفى، لما برهنّا عليه من استحالة رؤيته تعالى في الدنيا والآخرة ؛ خلافا لجماعة من العامّة والصوفيّة. ويستفاد من هذه العبارة فرق آخر بين الخوف والخشية. فتفطّن.
ومن المحتمل تعلّق «بالغيب» بالفعل الخاصّ المقدّر ؛ أي يؤمنون بالغيب أو الوصف كذلك، أي مؤمنين به ؛ كما قال :( الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ ) (١) إلى آخره. يعني بما غاب عن حواسّهم من الأمور الّتي عزمهم الإيمان بها كالبعث، والنشور، والحساب، والجنّة، والنار، وغيرها.
والتنوين في قوله :( مَغْفِرَةٌ ) للتعظيم ؛ كما في قوله :( وَعَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ ) (٢) وقول الشاعر :
له حاجب عن كلّ أمر يشينه
والمراد : العفو عن الذنوب والجرائم. والمراد بـ «الأجر الكبير» ما أعدّه الله لعباده الصالحين في الآخرة ممّا لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. أو ما كشف عنه في سورة «البيّنة» من قوله :( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
__________________
(١) البقرة : ٣.
(٢) البقرة : ٧.
وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ * جَزاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ) (١) . انتهى.
قال في الصافي : فإنّ الخشية ملاك الأمر والباعث على كلّ خير. انتهى.
وفي الحقائق : عن سهل في قوله :( ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ) الخشية سرّ، والخشوع ظاهر.
قال عمرو المكّيّ : اشترط على الراضين الخشية في رضاه عنهم، ولذلك أوجب لهم رضاه عنهم بأن يرضون عنه، ويخشونه في رضاه عنهم، ولا يكون ذلك إلّا بالاجتناب عن المحارم، وعند موافقتهم لموافقته ؛ أي يكرهوا ما كره، ويرضوا ما رضي. انتهى.
ويحتمل أن يراد بـ «الأجر الكبير» ما أشار سبحانه إليه في سورة «الرحمن» من قوله :( وَلِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ ) (٢) إلى آخره.
وقد تقدّم أنّ المؤمن بين خوفين : خوف ما مضى، وخوف ما بقي، فيكون إحدى الجنّتين لخوف ما مضى، والأخرى لخوف ما بقي.
وقال بعض العارفين : أي من خاف وهاب مقامه في مقام العتاب وتعيير ربّ الأرباب جنّتان : جنّة المشاهدة، وجنّة المواصلة، وجنّة المحبّة، وجنّة المكاشفة جنّة المعرفة، وجنّة التوحيد جنّة المقامات، وجنّة الحالات جنّة
__________________
(١) البيّنة : ٧ ـ ٨.
(٢) الرحمن : ٤٦.
القلب، وجنّة الروح جنّة الكرامات، وجنّة المداناة.
وقيل : هو المقام الّذي يقوم بين يدي ربّه يوم القيامة عند كشف الستور، وظهور حقائق الأمور، وسكوت الكلّ من الأنبياء والأولياء لظهور القدرة والجبروت.
ثمّ ليعلم أنّ من ثمرات الخشية : الورع، وهو كفّ النفس عن المحارم، والتحرّج منها.
وروي أنّه قال : صونوا دينكم بالورع(١) .
وقال : ملاك الدين الورع(٢) .
وفي الحديث القدسيّ : عبدي أدّ ما افترضت عليك تكن من أعبد الناس، وانته عمّا نهيتك عنه تكن من أورع الناس، واقنع بما رزقتك تكن من أغنى الناس.
( وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ ) صيغة الأمر في الآية ليست على ظاهرها، بل هي للتسوية كما هو أحد معانيها المجازيّة، يعني : إنّ إسراركم للقول، وإجهاركم به سواء عند الله، فإنّه يعلم ما تسرّون كما يعلم ما تعلنون.
وفي الكشّاف : إنّ معناه ليستو عندكم إسراركم وإجهاركم في علم الله بهما(٣) . انتهى.
__________________
(١) الكافي ٢ : ٧٦.
(٢) ثواب الأعمال : ٢٩٢، غرر الحكم : ٢٧١، تحف العقول : ٥١٣.
(٣) الكشّاف ٤ : ٥٧٩.
ولعلّ التعبير بالأمر الظاهر في المطلب كناية عن وجوب الاعتقاد بذلك.
وفي مجمع البيان : يعني أنّه عالم بإخلاص المخلص، ونفاق المنافق، فإن شئتم فأظهروا القول، وإن شئتم فأبطنوه، فإنّه عليم بضمائر القلوب، ومن علم إضمار القلب علم إسرار القول. قال ابن عبّاس : كانوا ينالون من رسول الله صلّى الله عليه وآله فيخبره به جبرئيل، فقال بعضهم لبعض : أسرّوا قولكم لئلّا(١) يسمع إله محمّد صلّى الله عليه وآله، فنزلت الآية(٢) . انتهى.
وكلمة «ذات» في «ذات الصدور» إمّا زائدة مقحمة لتزيين الكلام ؛ كما في قولهم : «رأيته ذات يوم، وذات ليلة، وذات مرّة» ؛ أي عليم بالصدور، والمراد بما يخفيه الشخص في الصدر.
وفي الكلّيّات : وعليم بذات الصدور ؛ أي ببواطنها وخفاياها. انتهى.
وإمّا بمعنى السريرة المضمرة من قولهم : عرفه من ذات نفسه ؛ أي من سريرة نفسه.
( أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ) .
قال صاحب الحقائق : فيه وعيد لمن يضمر في خاطره ما لا يليق بالحقّ، وكيف يخفى ما في القلوب والغيوب من المغيّبات المكنونة وهو موجدها ابتداء وعالم بها انتهاء، لأنّه من لطفه محيط بما في القلوب، خبير بما يجري في الصدور.
قال الواسطيّ : حجب الأشياء عن الوقوف على حقائقها، واستبدّ
__________________
(١) في المصدر : لكيلا.
(٢) مجمع البيان ١٠ : ٤١٣.
بمعرفة الحقائق فقال :( أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ) .
قال ابن عطاء : ألا يعلم من خلق الصدور وما يحدث فيها من حوادث العوارض. انتهى.
و «الهمزة» في «ألا يعلم» للإنكار الإبطاليّ ؛ كما عرفته في نظائره. فكما أنّ قوله «إنّه عليم» تعليل لما تقدّمه، فهذا برهان على إثبات علمه بالظواهر والبواطن. والظاهر أنّ «من خلق» فاعل لـ «يعلم» أي يعلم الخالق للخلق ما في صدورهم، ويحتمل أن يكون مفعولا والضمير المستتر فيه فاعلا، أي يعلم الله من خلقه.
والمراد بـ «اللطيف» في أسمائه تعالى : العالم بالشيء اللطيف ؛ كالبعوضة وأخفى منها ـ كما في بعض الروايات ـ أو الرفيق بعباده الّذي يوصل إليهم ما ينتفعون به في الدارين.
وب «الخبير» : العالم بما كان وما يكون ؛ لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، الواقف على حقائق الأشياء وبواطنها، وجملة( وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ) في محلّ النصب على الحاليّة.
( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَناكِبِها وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ) ذكر الله في هذه الآية بعض أنواع النعم، وبيّن لعباده بعض أصناف الكرم، لعلّهم يشكرون، وبآياته يهتدون، وهو أن سهّل لهم القرار في الأرض، والمعاش فيها ؛ بأن جعلها ساكنة مسخّرة يعملون فيها ما يشتهون، ولم يجعلها بحيث لم يتمكّنوا من التصرّف فيها لحزونتها وغلظتها، وصعوبة المشي والاختلاف فيها، والنيل منها، بل جعلها ذلو لا يتصرّفون
فيها كيف شاءوا، وحيث شاءوا، ومتى شاءوا، يزرعون فيها، ويبنون عليها، ويسكنون فيها، فهي كالذلول من الدوابّ لا تمتنع عن راكبها، يوجّه بها إلى أي جهة من الجهات شاء وأراد ؛ لا كالصعبة الحزون الّتي تجمح بصاحبها، ولا تطيعه فيما أراد، ولا يتمكّن من إمساكها.
والأمر في( فَامْشُوا فِي مَناكِبِها ) للإباحة والتسهيل.
وقيل : للترغيب ؛ أي فامشوا في طاعة الله. فتأمّل.
قال في الكشّاف : المشي في مناكبها مثل لفرط التذليل ومجاوزته الغاية، لأنّ المنكبين وملتقاهما من الغارب أرقّ شيء من البعير، وأنباه عن أن يطأه الراكب بقدمه ويعتمد عليه، فإذا جعلها في الذلّ بحيث يمشي في مناكبها لم يترك.
وقيل : مناكبها جبالها.
قال الزجّاج : معناه سهّل لكم السلوك في جبالها، فإذا أمكنكم السلوك في جبالها، فهو أبلغ التذليل.
وقيل : جوانبها(١) . انتهى.
وقيل : المراد بمناكب الأرض : طرقها وفجاجها.
وقال بعض العارفين : إنّ الخطاب في هذه الآية للأرواح، والمراد بالأرض : أرض القلوب، وبمناكبها : أسرارها، وأقطار عقولها، وسبل أنوارها إلى عالم الغيوب، فتأكل منها موائد المعارف، وأثمار الكواشف.
وعن بعضهم : خلق الله الأنفس ذلولا، فمن أذلّها بمخالفتها فقد نجّاها
__________________
(١) الكشّاف ٤ : ٥٨٠.
من الفتن والبلايا والمحن، ومن لم يذلّها واتّبعها أذلّته نفسه وأهلكته.
أقول : ومن هنا قال الشاعر :
النفس كالطفل إن تهمله شبّ على |
حبّ الرضاع وإن تفطمه ينفطم |
وقال الآخر :
والنّفس راغبة إذا رغّبتها |
وإذا تردّ إلى قليل تقنع(١) |
وقوله :( وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ) ؛ أي من رزقه المقسوم لكم حلالا طيّبا.
وقد اختلفوا في تفسير الرزق :
فذهب الأشاعرة إلى أنّ المراد به ما ينتفع به مطلقا، سواء كان بالتغذّي أو بغيره، وسواء كان مباحا أو حراما.
وذهب بعضهم إلى أنّه ما يربّى به الحيوان من الأغذية والأشربة.
وذهبت المعتزلة إلى أنّ المراد به ما جاز وصحّ الانتفاع به للحيوان بالتغذّي أو غيره، فلا يشمل الحرام.
والتحقيق : أنّ الرزق هو ما ينتفع به الحيوان مطلقا على وجه يحلّ شرعا، ولكن لو اختار المكلّف الحرام حرم من رزقه الحلال بقدر ما قسم له من الحلال.
وقد روي عن صفوان بن أميّة أنّه قال : كنّا جلوسا عند رسول الله صلّى الله عليه وآله إذ جاء عمر بن قرّة فقال : يا رسول الله صلّى الله عليه وآله إنّ الله كتب عليّ الشقوة، فلا أراني أرزق إلّا من دفّي بكفّي، فأذن لي بالغناء من غير
__________________
(١) جامع الشواهد ٣ : ١٠٢ ؛ وهو من قصيدة لأبي ذؤيب الهذليّ.
فاحشة! فقال : لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة ؛ أي عدوّ الله، لقد رزقك الله طيّبا فاخترت ما حرّم الله عليك من رزقك مكان ما أحلّ الله لك من حلاله، أما إنّك لو قلت بعد هذه المقالة ضربتك ضربا وجيعا(١) . انتهى، فتأمّل.
ويدلّ عليه أيضا : حكاية أمير المؤمنين عليه السلام مع السارق، فهي معروفة.
قوله :( وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ) وهذا بمنزلة قوله :( إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ) (٢) وقوله :( وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ) (٣) وقوله :( لَإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ ) (٤) ونحو ذلك. وفيه إيماء إلى الزجر عن استبدال الرزق الحلال بالحرام، لما فيه من المجازاة في يوم القيامة، فإنّه يوم الحساب.
وفي مجمع البيان : أي وإلى حكمه المرجع في القيامة.
وقيل : معناه وإليه الإحياء للمحاسبة، فهو مالك النشور، والقادر عليه. عن الجبّائيّ(٥) . انتهى.
والفرق بين الحشر والنشر ـ على ما ذكره السيّد نور الدين بن السيّد نعمة الله الجزائريّ رحمهما الله في فروق اللغات ـ أنّ الحشر لغة : إخراج الجماعة عن مقرّهم وإزعاجهم وسوقهم إلى الحرب ونحوه، ثمّ خصّ في عرف الشرع عند الإطلاق بإخراج الموتى عن قبورهم إلى الموقف للحساب والجزاء.
__________________
(١) بحار الأنوار ٥ : ١٥٠.
(٢) يونس : ٤.
(٣) يونس : ٥٦.
(٤) آل عمران : ١٥٨.
(٥) مجمع البيان ١٠ : ٤١٤.
وعن الراغب : ولا يقال الحشر إلّا للجماعة.
قلت : هذا في أصل اللغة، وإلّا فقد يستعمل في الواحد والإثنين، ومنه دعاء الصحيفة الشريفة : «وارحمني في حشري ونشري». والنشر : إحياء الميّت بعد موته، ومنه قوله تعالى :( ثُمَّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ ) (١) ؛ أي أحياه(٢) . انتهى.
قال الشاعر :
حياة ثمّ موت ثمّ نشر |
حديث خرافة يا أمّ عمرو |
أي : حياة بعد الموت.
( أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذا هِيَ تَمُورُ * أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ) فيه تهديد للعاصين، بل لمطلق المكذّبين، وزجر لهم عن مخالفته.
لا يقال : إنّ الله سبحانه لا يحويه مكان ؛ كما قال : «لا يسعني أرضي ولا سمائي»(٣) وكلمة «في» للظرفيّة، وهو منزّه من أن يكون محاطا بشيء، وهو بكلّ شيء محيط.
قال عليّ عليه السلام : ومن أشار إليه فقد حدّه، ومن حدّه فقد عدّه، ومن قال فيم فقد ضمّنه، ومن قال علام فقد أخلى منه، كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مع كلّ شيء لا بمقارنة، وغير كلّ شيء لا بمزايلة(٤) . انتهى.
__________________
(١) عبس : ٢٢.
(٢) انظر : المفردات : ١١٩.
(٣) عوالي اللئالئ ٤ : ٧.
(٤) نهج البلاغة : ٣٩.
هذا مع أنّه الّذي في السماء إله، وفي الأرض إله، فما وجه التخصيص مع أنّه لا يخلو منه مكان، بل الأرض والسماء بالنسبة إليه سواء؟
فإنّا نقول : إنّ لهذا الكلام وجوه :
منها : أنّ المراد أنّ من في السماء سلطانه وأمره ونهيه وتدبيره ورحمته، فإنّه ينزل من السماء أمره وحكمه.
وفي الكشّاف : من ملكوته في السماء، لأنّها مسكن ملائكته، وثمّ عرشه وكرسيّه واللوح المحفوظ، ومنها تنزل قضاياه وكتبه وأوامره ونواهيه(١) . انتهى.
ويدلّ على ذلك أيضا : رفع من يدعو الله لحاجة من حوائج الدنيا والآخرة يده إلى جانب السماء.
ومنها : أنّ أهل الجاهليّة كانوا يعتقدون أنّ الله في السماء فقيل لهم ذلك على حسب اعتقادهم، وقصّة نمرود وفرعون معروفة.
ومنها : أنّ المراد بالسماء سماء الالوهيّة وعظمة الربوبيّة الّتي هي أعلى من كلّ شيء، لا جهة العلوّ الحسّيّ.
ومنها : أنّ إثبات كونه في السماء ـ يعني إحاطة علمه بها ـ لا ينفي كونه في الأرض كذلك. فتأمّل.
ومنها : أنّ المراد بـ «من في السماء» الملك الموكّل بالعذاب.
وكيف كان، فالظرفيّة ليست بحقيقيّة ؛ كما لا يخفى على من برهن على امتناع كونه جسما، وكونه محتاجا إلى مكان، تعالى عن ذلك علوّا كبيرا.
__________________
(١) الكشّاف ٤ : ٥٨٠.
والخسف : شقّ الأرض وجعل الشخص غائبا فيها ؛ كما قال :( فَخَسَفْنا بِهِ وَبِدارِهِ الْأَرْضَ ) (١) والهمزة للإنكار الإبطاليّ، أي : لا تطمئنّوا باستقراركم في الأرض وسكونكم فيها منتفعين بما رزقكم الله فيها، فإنّ الله ربّما يريد أن يعذّبكم بمعاصيكم فيشقّ الأرض ويغيّبكم فيها ؛ كما فعل بقارون وأشباهه، أو يرسل عليكم الحجارة ؛ كما فعل بقوم لوط وأصحاب الفيل وأشباههم.
و «المور» : الاضطراب والتحرّك.
قال الطبرسيّ رحمه الله : والمعنى أنّ الله يحرّك الأرض عند الخسف بهم حتّى تضطرب فوقهم وهم يخسفون فيها حتّى تلقيهم إلى أسفل(٢) . انتهى.
و «أم» في قوله :( أَمْ أَمِنْتُمْ ) إلى آخره. من حروف العطف، ومنقطعة بمعنى «بل» فإنّها مسبوقة بهمزة الإنكار الّتي هي بمعنى النفي، و «أم» المتّصلة لا تقع بعد هذه الهمزة كما صرّح به صاحب المغني.
ثمّ قال : ومعنى «أم» المنقطعة الّتي لا يفارقها الإضراب، ثمّ تارة تكون له مجرّدا، وتارة تضمّن مع ذلك استفهاما إنكاريّا، أو استفهاما طلبيّا، فمن الأوّل :( هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ ) (٣) .
أمّا الأولى، فلأنّه لا يدخل الاستفهام على الاستفهام.
__________________
(١) الملك : ٨١.
(٢) مجمع البيان ١٠ : ٤١٤.
(٣) الرعد : ١٦.
وأمّا الثانية، فلأنّ المعنى على الإخبار عنهم ـ إلى أن قال ـ ومن الثاني :( أَمْ لَهُ الْبَناتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ) (١) تقديره : بل أله [البنات ولكم] البنون ؛ إذ لو قدّرت للإضراب المحض لزم المحال.
ومن الثالث قولهم : إنّها لإبل أم شاة(٢) ، فإنّ المقدّر : بل أهي شاة(٣) . انتهى.
وما نحن فيه من قبيل الثاني، فالتقدير : بلء أمنتم. فليتأمّل.
وقوله :( فَسَتَعْلَمُونَ ) إلى آخره. أي إنّكم قبل نزول العذاب وذوقه لا تعلمون حقيقة إنذاري بعلم اليقين، وأمّا بعد النزول تعلمونها بحقّ اليقين وعين اليقين ؛ كما قال :( كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ * ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ * كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ * لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ * ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقِينِ ) (٤) إلى آخره. انتهى.
و «النذير» وإن شاع استعماله في المنذر كالبشير في المبشّر، إلّا أنّ المراد به في الآية ونحوها : الإنذار، ويجوز في المضاف إلى ياء النفس حذف الياء وإبقاء الكسرة للدلالة عليها، وفي المنادى المضاف إليها لغات معروفة منها ذلك.
( وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ ) يعني اعتبروا أيّها المكذّبون بما فعلنا بمن كذّب من قبل من الأمم من إنزال العذاب عليهم بأنواعه ؛ من : الخسف، والصيحة، وإرسال الحجارة، والرجفة، والمسخ،
__________________
(١) الطور : ٣٩.
(٢) في المصدر : إنّها لإبل أم شاء التقدير : بل أهي شاء.
(٣) مغني اللبيب الباب الأوّل، بحث «أم» المنقطعة.
(٤) التكاثر : ٣ ـ ٧.
وغير ذلك، فاشكروا الله حيث جعلناهم عبرة لكم، ولم نجعلكم عبرة لهم.
والنكير بمعنى العقوبة، أي : فكيف كان عقوبتي لهم وتغييري ما أنعمت به عليهم لتغييرهم دين الحقّ؟! وقد قال الله :( إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ ) (١) .
وقيل : إنّ المعنى : كيف رأيتم إنكاري عليهم بإهلاكهم واستئصالهم، فالنكير يحتمل كونه بمعنى المنكر ـ بالفتح ـ وكونه بمعنى الإنكار ؛ نظير النذير، والياء محذوفة له لدلالة الكسرة كما فيه(٢) .
وقد حكي : أنّ ملكا من الملوك أمر غلمانه بأن يلقوا قاضيا من أعلى القصر لفضيحة صدرت عنه، فقال له : لم تفعل هذا بمثلي؟ قال : ليعتبر بك الناس، فلا يفعلوا مثل ما فعلت. فقال القاضي : فافعل هذا بغيري حتّى أعتبر أنا به، فضحك الملك فعفا عنه وأطلقه.
( أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ما يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ) أشار إلى بعض آثار قدرته ليستدلّوا به على كمال صنعه، وعجيب فعله، أي : أو لم ينظروا إلى هذا الصنف من الخلق كيف جعل فيه قوّة الطيران على الهواء، ووقوفه فيه، وإمساكه له فيه بحيث لا يسقط من الهواء على الأرض مع كثافة جسمه وجثّته، فربّما يصفّ بجناحيه، وربّما يدفّ، فلو لا قدرة الله وإمساكه لسقط على وجهه، فجعل بقدرته الهواء له كالماء للسمك يسبح فيه.
__________________
(١) الرعد : ١١.
(٢) أي كما في «النذير» وقد أشار إليه من قبل.
قال صاحب الحقائق : أشار إلى طيور الأرواح القدسيّة الّتي تطير في هواء الأزل والأبد بأجنحة الشوق والمحبّة ؛ باسطات أجنحتهنّ ببسط الأنس، قابضة لها برؤية عظمة القدس، فهناك محلّ القبض والبسط، ولو لا فضله وكرمه لفني في بروز سبحات ذاته، ولسقط من هواء لاهوتيّه إلى أرض قهره.
ثمّ حكى عن الحريريّ في قوله :( ما يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمنُ ) أنّه قال : أشار الحقّ إلى أنّه يتوكّل عليه الأولياء، ويسكن إليه الأصفياء بما صففن توكّلهنّ على الحقّ، فإذا توكّل عليه الوليّ شوقا إلى الملك الأعلى طيّره بجناح الأنس في هواء المحبّة، وأجلسه على بساط المعرفة، ويقبضه الحقّ بقدرته ويمسكه عواطف رحمته. انتهى.
و «يقبضن» عطف على «صافّات» فيكون في موضع الحال مثله، والأكثرون يمنعون من عطف الفعل على الاسم كالعكس.
قال الطبرسيّ رحمه الله : وإنّما عطف الفعل على الاسم، ومن الأصل المقرّر أنّ الفعل لا يعطف إلّا على الفعل، كما أنّ الاسم لا يعطف إلّا على الاسم، لأنّه وإن كان فعلا فهو في موضع الحال. فتقديره تقدير اسم [فاعل]، و «صافّات» حال، فجاز أن يعطف عليه، كأنّه(١) قال : صافّات وقابضات(٢) . انتهى.
وفي الكشّاف : فإن قلت : لم قيل «ويقبضن» ولم يقل «وقابضات»؟
__________________
(١) في المصدر : فكأنّه.
(٢) مجمع البيان ١٠ : ٤١٤.
قلت : لأنّ الأصل في الطيران هو صفّ الأجنحة، لأنّ الطيران في الهواء كالسباحة في الماء، والأصل في السباحة مدّ الأطراف وبسطها، وأمّا القبض فطارئ على البسط للاستظهار به على التحرّك، فجيء بما هو طارئ غير أصل بلفظ الفعل على معنى أنّهنّ صافّات، ويكون منهنّ القبض تارة بعد تارة كما يكون من السابح(١) . انتهى.
وحاصله : أنّ مقتضى الفعل التجدّد والحدوث، فيناسب الطارئ على الأصل دون الأصل.
و «فوقهم» يحتمل أن تكون ظرفا لصافّات، وأن تكون حالا، وتكون «صافّات» حالا من الضمير المستكنّ في «فوقهم» و «ما يمسكهنّ» قيل : يجوز أن يكون مستأنفا، وأن يكون حالا من الضمير في «يقبضن» ومفعول «يقبضن» محذوف ؛ أي أجنحتهنّ. انتهى.
وفي بعض التفاسير : إنّ المعنى : ألم يستدلّوا بثبوت الطير في الهواء على قدرتنا أن نفعل بهم ما تقدّم وغيره من العذاب. انتهى.
وفي التعبير بلفظ( الرَّحْمنُ ) إشارة إلى أنّ إمساكهنّ في الهواء وعدم سقوطهنّ مقتضى الصفة الرحمانيّة.
وفي قوله :( إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ) أي : عليم، إشارة إلى أنّ أفعاله تعالى لا تكون إلّا بحكمة ومصلحة.
قال الطبرسيّ رحمه الله : والبصير في أسمائه، هو الّذي يشاهد الأشياء كلّها ظاهرها وخافيها من غير جارحة، فالبصر في حقّه تعالى عبارة عن
__________________
(١) الكشّاف ٤ : ٥٨١.
الصفة الّتي ينكشف بها كمال نعوت المبصرات، وفي الحديث : سمّيناه بصيرا، لأنّه لا يخفى عليه ما يدرك بالأبصار من لون أو شخص أو غير ذلك، ولم تصفه ببصر لحظة العين. انتهى.
( أَمَّنْ هذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ إِنِ الْكافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ * أَمَّنْ هذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ) وكلمة «أم» في الآيتين أيضا منقطعة بمعنى بل الإضرابيّة خاصّة، فإنّ الاستفهام لا يدخل على الاستفهام، لأنّ «من» فيهما للاستفهام الإنكاريّ في موضع الرفع على كونه مبتدأ، وبهذا يحتجّ على البصريّين في زعمهم أنّ المنقطعة أبدا بمعنى، بل والهمزة جميعا، أللّهمّ إلّا أن يدّعوا التوكيد، وهو خلاف الأصل لا يرتكب إلّا بالدليل.
فالحقّ ما نصّ عليه ابن هشام من أنّها قد تستعمل في مجرّد الإضراب ؛ كما في الآيتين وأشباههما، وقد تستعمل متضمّنة للاستفهام الإنكاريّ ؛ كما في قوله تعالى :( أَمْ لَهُ الْبَناتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ) (١) ومتضمّنة للاستفهام الطلبيّ ؛ كما في قولهم : إنّها لإبل أم شاة.
وعن أبي عبيدة : إنّها قد تستعمل بمعنى الاستفهام المجرّد ؛ كما في قول الشاعر :
كذبتك عينك أم رأيت بواسط |
غلس الظّلام من الرّباب خيالا |
وقد اختلف في خبر «من» ففي مجمع البيان : إنّ هذا مبتدأ ثان، و «الّذي» خبره، وقد وصل بالمبتدأ والخبر، وهو قوله :( هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ ) و «ينصركم»
__________________
(١) الطور : ٣٩.
صفة الجند(١) . انتهى.
وحاصله : أنّ «الّذي» مع صلته وعائده خبر لـ «هذا» الّذي هو مبتدأ ثان، ومجموع هذه الجملة في محلّ الرفع ليكون خبرا عن «من» الّذي هو مبتدأ أوّل، ويسمّى هذا المجموع بالجملة الصغرى، كما يسمّى المجموع من المبتدأ الأوّل وهذه الجملة بالجملة الكبرى. وقد فسّروا الكبرى بالجملة الاسميّة الّتي خبرها جملة، والصغرى بالجملة المبتنية على المبتدأ، وقد ذكروا في قوله تعالى :( لكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي ) (٢) أنّ الأصل : لكن أنا هو الله ربّي.
قال في المغني : ففيها ثلاث مبتدءات إذا لم يقدّر «هو» ضميرا له سبحانه، ولفظ الجلالة بدلا منه أو عطف بيان عليه ـ كما جزم به ابن الحاجب ـ بل قدّر ضمير الشأن وهو الظاهر، ثمّ حذفت همزة «إن» حذفا اعتباطيّا ؛ أي بلا سبب، وقيل : حذفا قياسيّا بأن نقلت حركتها ؛ أي إلى النون من «لكن» ثمّ حذفت، ثمّ أدغمت نون «لكن» في نون «أنا». انتهى.
وفي أكثر التفاسير : إنّ «من» مبتدأ، و «هذا» خبره، و «الّذي» نعت لـ «هذا» أو بدل عنه أو عطف بيان عنه. لا يقال : «الجند» في معنى الجمع، فكيف وحّدت الإشارة والضمير الراجع إليه في «ينصركم» فإنّ لفظ «الجند» موحّد ؛ كما في قوله :( جُنْدٌ ما هُنالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزابِ ) (٣) . قيل : و «ينصركم» نعت لـ «جند» محمول على اللفظ ولو جمع على المعنى جاز. انتهى.
__________________
(١) مجمع البيان ١٠ : ٤١٤.
(٢) الكهف : ٣٨.
(٣) ص : ١١.
وقال الطبرسي رحمه الله : أي لا جند لكم ينصركم منّي ويمنعكم من عذابي إن أردت عذابكم. عن ابن عبّاس.
ولفظ «الجند» موحّد، ولذلك قال : «هذا الّذي» وكأنّه سبحانه يقول للكفّار : بأيّ قوّة تعصونني، ألكم جند يدفع عنكم عذابي؟ بيّن بذلك أنّ الأصنام لا يقدرون على نصرتهم(١) . انتهى.
و «الغرور» بالضمّ : الباطل. وعن ابن السكّيت : إنّه ما رأيت له ظاهرا تحبّه وفيه باطن مكروه ومجهول. انتهى.
ويستعمل في الخدعة، ومنه الغرور بالفتح للشيطان، فإنّه يخادع الإنسان بمتاع الدنيا حتّى يدخله النار.
و «الغرّة» بالكسر : الغفلة.
قال الطبرسيّ رحمه الله : أي ما الكافرون إلّا في غرور من الشيطان ؛ يغرّهم بأنّ العذاب لا ينزل بهم.
وقيل : معناه : ما هم إلّا في أمر لا حقيقة له من عبادة الأوثان، يتوهّمون أنّ ذلك ينفعهم والأمر بخلافه(٢) . انتهى.
والضمير في «أمسك رزقه» راجع إلى «الله» إن أريد بالمشار إليه أصنامهم الّتي يتوهّمونها آلهة.
والمراد بإمساك الرزق : إمساك أسبابه ؛ كالمطر ونحوه.
قيل : جواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله ؛ أي «فمن يرزقكم» أي : لا رازق لكم غيره انتهى.
__________________
(١ و ٢) مجمع البيان ١٠ : ٤١٤.
وعن الفرّاء : قوله :( أَمَّنْ هذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ ) إلى آخره. تعريف حجّة ألزمها الله العباد فعرفوا فأقرّوا بها ولم يردّوا لها جوابا، فقال سبحانه :( بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ) (١) . انتهى.
و «اللجاجة» و «اللجوجة» : ملازمة الشيء ومواظبته والاستمرار عليه.
و «العتوّ» : التجبّر والتكبّر، وقد تقلب الواو ياء بعد إبدال الضمّة كسرة، فيقال : عتى بضمّ المهملة أو كسرها.
و «النفور» : التباعد عن الحقّ والإيمان.
وفي الآية إشارة إلى أنّ الحجّة قد تمّت على هؤلاء الكفّار العابدين للأوثان، وأنّ الحقّ لم يؤثّر في قلوبهم القاسية الّتي طبع ورين وختم عليها، بل زادهم طغيانا وكفرا ؛ كما قال :( وَإِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زادَتْهُ هذِهِ إِيماناً ) ـ إلى قوله ـ( وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَماتُوا وَهُمْ كافِرُونَ ) (٢) .
( أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلى وَجْهِهِ أَهْدى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ) .
قال صاحب الحقائق : شبّه الله صاحب النفس الّذي يمشي قلبه في ظلماتها لا يدري أين يمشي بالأعمى الّذي يخبط خبط العشواء في ظلمات هو كمن يمشي روحه في طرق الملكوت بنعت المعرفة والسريان في أنوار المشاهدة.
قال سهل : مكبّا، أي : مطرقا إلى هوى نفسه بجبلّة خلقته بعد هدى ربّه
__________________
(١) مجمع البيان ١٠ : ٤١٥.
(٢) البقرة : ١٢٤ ـ ١٢٥.
أهدى أم من يمشي سويّا، يعني المؤمن المهتدي على صراط مستقيم، أي : على شريعة طرق التوحيد. انتهى.
والمكبّ على الوجه هو المنكّس رأسه إلى الأرض بحيث لا يبصر الطريق، ولا ينظر أمامه، ولا يمينه، ولا شماله، شبّه به الكافر المقلّد الّذي لم يشمّ رائحة التحقيق، فلا يدري أمحقّ هو أم مبطل، فيميل مع كلّ ناعق ؛ كما شبّه المؤمن المحقّ الّذي سلك طريق الحقّ برهانه القاطع، وعرف موارد الحقّ ببيانه الساطع، بالبصير المستوي بقيامه يمشي على صراط مستقيم بحيث لا يعثر ولا يزلّ قدمه في طريق من طرقه.
وقيل : إنّ الكافر المكبّ على معاصي الله يحشره الله يوم القيامة على وجهه بخلاف المؤمن، فإنّه يمشي على الصراط مستويا قائما.
وقيل : المراد بالأوّل أبو جهل، وبالثاني رسول الله.
وقيل : حمزة بن عبد المطّلب عليه السلام(١) .
قال في الكشّاف : فإن قلت : ما معنى «يمشي مكبّا على وجهه» وكيف قابل «يمشي سويّا على صراط مستقيم»؟
قلت : معناه : يمشي معتسفا في مكان معتاد غير مستو فيه انخفاض وارتفاع، فيعثر كلّ ساعة فيخرّ على وجهه منكبّا، [فحاله] نقيض حال من يمشي سويّا ؛ أي قائما سالما من العثور والخرور، أو مستوي الجهة قليل الانحراف خلاف المعتسف الّذي ينحرف هكذا أو هكذا(٢) إلى آخره. انتهى.
__________________
(١) انظر : الكشّاف ٤ : ٥٨٢.
(٢) الكشّاف ٤ : ٥٨٢.
و «المكبّ» : اسم فاعل ؛ من «أكبّ الشيء» فهو إمّا من الأفعال الّتي مجرّدها متعدّ ومزيدها لازم مطاوع لمجرّدها، فيقال : كببته، فأكبّ ؛ نظير قولهم : تشعبّت الريح السحاب أي كشفته وأزالته فانقشع ونزفت البئر فأنزفت ؛ أي ذهب ماؤها، ونسلت ريش الطائر فانسلّ ؛ إذ من الأفعال الّتي جاءت للصيرورة ؛ كما في : أغدّ البعير، أي : صار ذا غدّة، فمعنى «مكبّا» صائرا إذا كبّ، أو من الأفعال المتضمّنة للدخول كقولهم : أحرم الرجل ؛ إذا دخل في الحرم، وأشأم : إذا دخل الشام، وأتهم : إذا دخل تهامة، وأنجد : إذا دخل النجد، وأيمن : إذا دخل اليمن. فمعنى «مكبّا» داخلا في الكبّ.
وهذان الوجهان أولى من الأوّل لندرته. وقد صرّح جماعة بأنّ مطاوع «كبّ» «انكبّ» وبأنّه لا شيء من بناء «أفعل» مطاوعا.
( قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ ) ذكّرهم الله بعض نعمائه عليهم ليشكروا، ووبّخهم على تركهم الشكر في كثير من الأوقات، فإنّ الشكر هو صرف العبد جميع ما أعطاه الله من النعم فيما يحبّه ويأمر به، ومنها : الوجود الّذي هو أعظم النعم وأصلها وأساسها، ولذا قدّمه فقال :( الَّذِي أَنْشَأَكُمْ ) ؛ أي أخرجكم من العدم إلى الوجود، لإيصال الفيض والجود.
قيل : أي ابتدأكم وخلقكم، وكلّ من ابتدأ شيئا فقد أنشأه.
ومنها : القوّة السامعة، ليسمعوا بها المسموعات، فينتفعوا بالمواعظ الإلهيّة.
ومنها : القوّة الباصرة، ليبصروا بها المبصرات، فينتفعوا بمشاهدة آثار
صنع الله وقدرته، وإنّما جمع الأبصار لاختلاف أجناس المبصرات، دون السمع لاختصاصه بالأصوات.
ومنها : الفؤاد، ليتعقّلوا به الأمور، ويتميّزوا بينها، فيتفكّروا في آيات الله فيصلوا به إلى مراتب العلم واليقين. جمعه لما تقدّم من اختلاف أجناس متعلّقاته وظاهر كلمات أهل اللغة أنّ الفؤاد والقلب مترادفان، ولكن فسّره بعضهم بأنّه غشاء القلب، فإذا رقّ نفذ القول فيه وخلص إلى ما وراءه، وإذا غلظ تعذّر وصوله إلى داخله.
قيل : ولا شيء في بدن الإنسان ألطف من الفؤاد، ولا أشدّ تأذّيا منه.
وكيف كان، فإذا صرف العبد هذه الثلاثة في غير ما خلقت لأجله فقد كفر بأنعم الله ؛ وقد قال :( إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً ) (١) وقال :( وَلَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها وَلَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ) (٢) إلى آخره.
وجملة( قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ ) مستأنفة مخبرة بقلّة شكرهم ؛ كما صرّح به بعضهم. و «ما» مزيدة للتأكيد والتحقيق والمبالغة في القلّة، ويحتمل كونها موصولة حرفيّة تؤوّل مع صلته بالمصدر، ولذا تسمّى مصدريّة ؛ أي قليلا شكركم، فالقلّة راجعة إلى الفعل، ويحتمل رجوعها إلى الفاعل ؛ كما هو مؤدّى قوله تعالى :( وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ ) إن جعلنا الشكور بمعنى
__________________
(١) الإسراء : ٣٦.
(٢) الأعراف : ١٧٩.
الشاكر، وأمّا إن جعلناه بمعنى كثير الشكر، فلا ينفي كثرة الشاكرين إذا كان شكر كلّ منهم قليلا، ثمّ إنّ قلّة الفعل لا تقتضي قلّة الفاعل ؛ بخلاف العكس. فتدبّر.
ونصب «قليلا» على كونه وصفا لظرف محذوف وهو «الحين». ويحتمل أن يكون لنيابته عن المصدر، أي : وتشكرون شكرا قليلا. ومن المحتمل بعيدا كون «ما» نافية، فيكون المراد نفي شكرهم بالمرّة. فتأمّل.
( قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ * وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ * قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ وَإِنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ) هذا تذكير آخر، بل برهان على أنّ الملجأ في جميع الأمور هو الله الحقّ دون الأصنام الّتي كانوا يعبدونها على الباطل، فإنّه هو الخالق للجميع، القادر على كلّ شيء، وهو المرجع في القيامة للحساب والمجازاة دون هذه التماثيل الّتي كانوا يعكفون عليها بعد أن نحتوها وخلقوها بأيديهم، وهي لا تقدر على نفع ولا ضرّ، ولا على خلق مثل ذباب، ولا على مجازاة وحساب.
و «الذرء» بالهمزة : الخلق ؛ كما في الآية ؛ وقوله :( وَلَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ ) (١) إلى آخره. ومنه الذرّيّة بتثليث الذال وأصلها الذروءة على وزن الفعولة، فأبدلت الهمزة ياء ؛ كما في «النبيء» فإنّه من النبأ على ما قيل.
وقيل : إنّها من الذرّ، وهو البثّ والتفريق، لأنّه تعالى ذرّهم ونشرهم في الأرض، فالوزن فعلولة فأبدلوا الراء الأخيرة ياء، ثمّ أدغمت الواو فيها بعد قلب الواو ياء.
__________________
(١) الأعراف : ١٧٩.
و «متى» استفهام وسؤال عن الزمان، والمراد بالوعد ما يشمل الوعيد، و «اللام» فيه للعهد الحضوريّ أو الذكريّ لدلالة «وإليه تحشرون» على الحشر، أو الخارجيّ وهو المعروف في مخاطبات الأنبياء مع الأمم في إرشادهم إلى الاعتقاد بالقيامة والحساب، وإنكار الكفّار جميع ذلك، وسؤالهم عن وقت ذلك تعنّتا واستهزاء، ففي سورة الأعراف :( يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ) (١) ونحوها آيات أخرى دالّة على أنّ علم الساعة مخصوص بالله تعالى لا يعلمه سواه.
وفي الحقائق : قوله جلّت عظمته :( قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ ) ففي مكنون علمه فيما جرى في الأزل عن الخليقة وإن كان صدّيقا مرسلا، أو ملكا مقرّبا، فيكون عنهم مستورا كما كان في ستر الأزل قبل الخلق، ولو أمعنت النظر يا صاحبي في العلم فإنّ حقيقة العلم منفيّ عن الخلق ؛ إذا الخلق لا يعلم حقيقة الأشياء، فإنّ حقيقة علم الأشياء لمنشئها لا غير، وذلك قوله تعالى :( أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ) أثبت العلم بالحقيقة لنفسه.
قال يحيى بن معاذ : أخفى الله علمه في عباده، فكلّ يتّبع أمره على جهة الإشفاق لا يعلم ما سبق له، وبماذا يختم له، وذلك قوله :( إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ ) . انتهى.
ويظهر منه أنّ «اللام» في «العلم» للجنس أو للاستغراق الحقيقيّ، فمفاد
__________________
(١) الأعراف : ١٨٧.
هذا الكلام أنّ حقائق الأشياء كما هي علمها خاصّ بالله، وخارج عن الطاقة البشريّة، ولكن يترشّح على العلماء وإن كانوا رسلا أو ملكا على حسب طاقتهم البشريّة والإمكانيّة، ولذا قيل :
كيف الوصول إلى سعاد ودونها |
قلل الجبال ودونهنّ حتوف |
|
والرجل حافية ومالي مركب |
والكفّ صفر والطريق مخوف |
وكيف كان، فكلمة «إنّما» تفيد حصر العلم مطلقا فيه تعالى من قبيل حصر الصفة في الموصوف، ومن المحتمل كون «اللام» نائبة عن الضمير على ما جوّزه الكوفيّون ؛ أي إنّما علم هذا الوقت عند الله. فتأمّل.
وكيف كان، فالقصر قصر أفراد، لاعتقاد المخاطبين الشركة في صفة العلم المطلق أو الخاصّ بينه تعالى وبين غيره، وحقيقيّ، فإنّ العلم المذكور لا يتجاوزه إلى غيره في الحقيقة ونفس الأمر. فليتأمّل.
ومثله القصر في قوله :( وَإِنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ) فإنّه أيضا أفراد، ولكنّه غير حقيقيّ، ومن قبيل قصر الموصوف على الصفة.
و «النذير» المنذر، أي : المخوّف من العذاب.
و «المبين» الظاهر صدقه، أو المظهر حجّته بالبيّنات والآيات.
قال الطبرسي رحمه الله : أي مبيّن لكم ما أنزل الله إليّ من الوعد والوعيد والأحكام(١) .
( فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ) أشار بالتعبير عن المستقبل بلفظ الماضي إلى أنّ وقوع هذا الوعد أمر يقينيّ
__________________
(١) مجمع البيان ١٠ : ٤١٥.
لا ريب فيه، فهو بمنزلة الماضي الواقع قطعا، هذا مع أنّ الماضي والمستقبل والحال بالنسبة إلى الحقّ تعالى سواء ؛ كما حقّق في محلّ آخر.
نعم، عن مجاهد : أنّ المراد بـ «ما رأوه» ما وقع على الكفّار يوم بدر من القتل والأسر، فلا حاجة إلى التأويل، ولكنّه خلاف الظاهر.
و «الزلفة» و «الزلفى» القربى، ومنه قوله :( وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ) (١) أي قربت ؛ أي فلمّا رأوا العذاب الموعود قريبا منهم.
وقيل : أي معاينة بعين اليقين.
وقيل : إنّ المعنى إذا بعثوا ورأوا القيامة قد قامت ورأوا ما أعدّ لهم من العذاب «سيئت وجوه الّذين كفروا» : اسودّت وجوههم.
وقيل : أي قبحت وجوههم بلون السواد.
وقيل : أي ظهرت على وجوههم آثار الكآبة والغمّ والحسرة، ونالهم السوء والخزي والافتضاح.
وقيل : ظهر كذبهم فيما يدّعون.
قوله «وقيل» إلى آخره، القائل بهذا القول لهم الملائكة، أو خصوص الزبانية، أو الأنبياء، أو المؤمنون.
و «تدّعون» بسكون «الدال» من الدعاء أو بتشديدها على القراءة المشهورة من الادّعاء، والمعنى واحد ؛ كما في «تدخرون» و «تدّخرون».
قيل : أي تدّعون أن لا جنّة ولا نار، ولا حساب ولا مجازاة، وأن لا حياة إلّا حياتنا الدنيا نموت ونحيى وما يهلكنا إلّا الدهر.
__________________
(١) ق : ٣١، والشعراء : ٩٠.
وقيل : أي تستعجلون وتدعون الله بتعجيله.
ويؤيّده : جملة من الآيات القرآنيّة.
وقيل : المراد بالّذين كفروا هم الّذين أنكروا ولاية عليّ عليه السلام ومقامه، ولا شكّ في كفرهم باطنا، وقد أفتى جماعة من أصحابنا بكفرهم ونجاستهم ظاهرا أيضا، لإنكارهم ما هو الضروريّ من القرآن والنصّ المتواتر عن النبيّ صلّى الله عليه وآله. فتأمّل.
وقد ورد أنّ هذه الآية نزلت في عليّ عليه السلام وأصحابه الّذين عملوا ما عملوا فيرون أمير المؤمنين عليه السلام في أغبط الأماكن، فيسيء وجوههم، ويقال لهم «هذا الّذي كنتم به تدّعون» الّذي انتحلتم اسمه وتسمّيتم أنفسكم بهذا اللقب، وهم خلفاء بني أميّة وبني العبّاس الّذين سمّوا أنفسهم بأمير المؤمنين.
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم القمّيّ رحمه الله بعد ذكر هذه الآية قال عليه السلام : إذا كان يوم القيامة ونظر أعداء أمير المؤمنين عليه السلام ما أعطاه الله من المنزلة الشريفة العظيمة وبيده لواء الحمد وهو على الحوض يسقي ويمنع ؛ تسودّ وجوه أعدائه، فيقال لهم «هذا الّذي كنتم به تدّعون» أي : هذا الّذي كنتم به تدّعون منزلته وموضعه واسمه(١) . انتهى.
( قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنا فَمَنْ يُجِيرُ الْكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ * قُلْ هُوَ الرَّحْمنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ ) أشار إلى أنّ الله هو الملجأ والمعاذ لمن آمن به ولاذ، وأنّ الكافرين به لا معاذ
__________________
(١) تفسير القمّيّ ٢ : ٣٧٨.
لهم ولا ملاذ، وإلى أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله هو الوسيلة إلى النجاة عن عذاب الله، فإنّه الداعي إلى الإيمان به تعالى، بل وجوده بين قومه مانع عن نزول العذاب الدنيويّ، كما قال تعالى :( وَما كانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ) (١) .
قيل : إنّ الكفّار كانوا يتمنّون موت النبيّ صلّى الله عليه وآله وموت أصحابه، فقيل لهم «إن أهلكني الله ومن معي» بأن يميتني ويميت أصحابي، فمن الّذي ينفعهم في دفع العذاب عنهم ويؤمنهم من العذاب، فإنّه واقع بهم لا محالة.
وقيل : معناه : أرأيتم إن عذّبني الله ومن معي، أو رحمنا بأن غفر لنا، فمن يجيركم؟ أي : نحن مع إيماننا بين الخوف والرجاء، فمن يجيركم مع كفركم من العذاب ولا رجاء لكم كما للمؤمنين، نقل هذين القولين شيخنا الطبرسيّ رحمه الله في مجمع البيان(٢) . ولكنّه فسّر «أهلكني» بيميتني و «رحمنا» بتأخير آجالنا. فليتأمّل.
وفي الكشّاف : كان كفّار مكّة يدعون على رسول الله صلّى الله عليه وآله وعلى المؤمنين بالهلاك، فأمر بأن يقول لهم : نحن مؤمنون متربّصون لإحدى الحسنيين : إمّا أن نهلك كما تتمنّون فننقلب إلى الجنّة، أو نرحم بالنصرة والإدالة للإسلام كما نرجو، فأنتم ما تصنعون؟ من يجيركم ـ وأنتم كافرون ـ من عذاب النار؟ لا بدّ لكم منه، يعني : إنّكم تطلبون لنا الهلاك الّذي هو استعجال للفوز والسعادة وأنتم في أمر هو الهلاك الّذي لا هلاك بعده،
__________________
(١) الأنفال : ٣٣.
(٢) مجمع البيان ١٠ : ٤١٥.
وأنتم غافلون لا تطلبون الخلاص منه. أو إن أهلكنا الله بالموت فمن يجيركم بعد موت هداتكم، والآخذين بحجزكم من النار، وإن رحمنا بالإمهال والغلبة عليكم وقتلكم فمن يجيركم ؛ فإنّ المقتول على أيدينا هالك. أو إن أهلكنا الله في الآخرة بذنوبنا ونحن مسلمون، فمن يجير الكافرين وهم أولى بالهلاك لكفرهم، وإن رحمنا بالإيمان فمن يجير من لا إيمان له(١) . انتهى.
و «الرؤية» في «أرأيتم» : بصرته، أو عرفانيّة فلا تتعدّى إلى اثنين ؛ كما في قوله :( أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ) (٢) وقد يتوهّم أنّ «أرأيتم» بمعنى : أخبروني، وقد نقل من الإنشاء إلى الإفشاء ؛ كما في( أَرَأَيْتَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَ ) (٣) أي : أخبرني.
وفيه ما لا يخفى، لأنّهم ملتزمون في «التاء» الملحقة بهذا الفعل الإفراد والتذكير، فينافيه الجمعيّة.
قال في المغني : ومن غريب أمر «التاء» الاسميّة أنّها جرّدت عن الخطاب والتزم فيها لفظ التذكير والإفراد في أرأيتكما وأ رأيتكم وأ رأيتك وأ رأيتكنّ. انتهى.
قوله :( فَمَنْ يُجِيرُ ) جواب عن الشرط، و «من» كلمة استفهام للإنكار، فالمراد أنّه لا مجير للكافرين.
قوله :( هُوَ الرَّحْمنُ ) إلى آخره.
__________________
(١) الكشّاف ٤ : ٥٨٣.
(٢) الماعون : ١.
(٣) الإسراء : ٦٢.
قال الطبرسيّ رحمه الله : أي إنّ الّذي أدعوكم إليه هو الرحمن الّذي عمّت نعمته جميع الخلائق(١) . انتهى.
ف «الرحمن» أيضا من أسمائه الخاصّة كـ «الله» كما يستفاد من قوله :( قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى ) (٢) الآية. وفي سورة الفرقان :( وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمنِ قالُوا وَمَا الرَّحْمنُ أَنَسْجُدُ لِما تَأْمُرُنا وَزادَهُمْ نُفُوراً ) (٣) .
قال في الكشّاف : فإن قلت لم أخّر مفعول «آمنّا» وقدّم مفعول «توكّلنا»؟
قلت : لوقوع آمنّا تعريضا بالكافرين حين ورد عقيب ذكرهم، كأنّه قيل : آمنّا ولم نكفر كما كفرتم، ثمّ قال : وعليه توكّلنا خصوصا لم نتّكل على ما أنتم متّكلون عليه من رجالكم وأموالكم(٤) . انتهى.
وفي تقديم الظرف على الفعل دلالة على الحصر، وإشارة إلى أنّه توجّه بكلّيّته على الحقّ، وقصر نظره عن غيره في جميع أموره، فإنّه هو الغنيّ المطلق، وما سواه فقراء إليه، فمن يتوكّل على الله فهو حسبه.
وفسّر التوكّل بانقطاع العبد إليه تعالى في جميع ما يأمله من المخلوقين، ويلزمه ترك الحرص على الدنيا، وترك السعي فيها، والرضا بما قسمه الله له. والكلام في التوكّل طويل الذكر، فمن أراده فليرجع إلى كتب الأخلاق.
قوله :( فَسَتَعْلَمُونَ ) إلى آخره. قرئ بالتاء، فالخطاب للكفّار
__________________
(١) مجمع البيان ١٠ : ٤١٥.
(٢) الإسراء : ١١٠.
(٣) الفرقان : ٦٠.
(٤) الكشّاف ٤ : ٥٨٣.
الزاعمين أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله على ضلال مبين في دعوته النبوّة وإخباره بالبعث والحساب، وقد قال الّذين سبقوهم لأنبيائهم «إن أنتم إلّا في ضلال مبين» يعني : ستعلمون يا معاشر الكفّار يوم القيامة من هو في ضلال مبين ؛ أنحن أم أنتم؟
وكذلك إن قرئ بالياء، فمرجع الضمير أيضا هؤلاء الكفّار أو جميعهم من السابقين واللاحقين، وفي الآية تهديد ووعيد لمن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فهي نظير قوله تعالى في سورة القمر :( أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ * سَيَعْلَمُونَ غَداً مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ ) (١) .
وروي في تفسير الآية أنّ المراد : فستعلمون يا معشر المكذّبين من حيث أنبأتكم رسالة ربّي في ولاية عليّ والأئمّة من بعده من هو في ضلال مبين.
( قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِماءٍ مَعِينٍ ) (٢) برهان على أنّ الله هو المعين لمن استعان به، والمجير لمن استجار إليه، والمفزع لمن توكّل عليه، وأنّه لا معين، ولا مجير، ولا مفزع سواه، ولا إله غيره.
و «أصبح» بمعنى صار في وقت الصبح ؛ كأمسى بمعنى صار في المساء، وأضحى بمعنى صار في الضحى، أو بمعنى كان.
قال الشارح الرضيّ : إنّ هذه الثلاثة تكون ناقصة وتامّة، والناقصة بمعنيين :
إمّا بمعنى صار من غير اعتبار الأزمنة الّتي يدلّ عليها تركيب الفعل ؛ أعني الصبح والمساء والضحى، بل باعتبار الزمن الّذي يدلّ عليه صيغة
__________________
(١) القمر : ٢٥ ـ ٢٦.
(٢) الملك : ٣٠.
الفعل أعني الماضي والحال والاستقبال.
وإمّا بمعنى كان في الصبح، وكان في المساء، وكان في الضحى. ويقترن في هذا المعنى الأخير مضمون الجملة، أعني مصدر الخبر مضافا إلى الاسم بزمان الفعل، أعني الّذي يدلّ عليه تركيبه، والّذي يدلّ عليه صيغته، فمعنى أصبح زيد أميرا ؛ أي إمارة زيد مقترنة بالصبح في الزمان الماضي، ومعنى يصبح قائما أنّ قيامه مقترن بالصبح في الحال والاستقبال.
قال : وتكون تامّة كقولنا أصبحنا والحمد لله، وأمسينا والملك لله ؛ أي وصلنا إلى الصبح والمساء ودخلنا فيهما، وكذا أضحينا، فيدلّ كلّ منهما على الزمانين. انتهى.
ولا يخفى أنّ هذه الأفعال إذا وقعت ناقصة فالمنصوب بعدها خبر، وإذا استعملت تامّة فالمنصوب حال.
و «الغور» مصدر «غار الماء» : إذا ذهب في الأرض ونضب. والمراد به في الآية الغائر أو معناه المصدريّ، فوصف الماء به من قبيل «زيد عدل» و «درهم ضرب» و «ماء سكب» وأمثالها ممّا أريد منه المبالغة.
و «المعين» فعيل من «معين الماء» : إذا جرى، أو مفعول من «عان الماء» : إذا استنبطه واستخرجه، أو من «عان الشيء» : إذا نظر إليه ورآه. فالماء المعين هو الظاهر المحسوس بالعين.
وعن بعضهم أنّه أراد بقوله «ماؤكم» ماء زمزم وبئر ميمون، وهي بئر عادية قديمة، وكان ماؤهم من هاتين البئرين. و «المعين» : الّذي تناله الدلاء، وتراه العيون.
وفي تفسير القمّيّ رحمه الله قال : أرأيتم إن أصبح إمامكم غائبا فمن يأتيكم بإمام مثله حدّثنا محمّد بن جعفر قال : حدّثنا محمّد بن أحمد، عن القاسم بن محمّد قال : حدّثنا إسماعيل بن عليّ الفزاريّ، عن محمّد بن جمهور، عن فضالة بن أيّوب قال : سئل الرضا عليه السلام عن قول الله عزّ وجلّ :( قُلْ أَرَأَيْتُمْ ) إلى آخره. فقال عليه السلام : «ماؤكم أبوابكم ؛ أي الأئمّة عليهم السلام والأئمّة أبواب الله بينه وبين خلقه، فمن يأتيكم بماء معين يعني بعلم الإمام عليه السلام(١) . انتهى.
ونحوه ما في التفسير الصادقيّ، وروي أنّ هذه الآية نزلت في الإمام القائم عليه السلام يقول : إن أصبح إمامكم غائبا عنكم لا تدرون أين هو فمن يأتيكم بإمام ظاهر يأتيكم بأخبار السماوات والأرض، وحلال الله وحرامه. ثمّ قال : والله ما جاء تأويل هذه الآية ولا بدّ أن يجيء تأويلها(٢) . انتهى.
ولا منافاة بين تفسير «الماء» تارة بالإمام، وأخرى بعلمه ؛ كما لا يخفى.
فإن قيل : ما وجه المناسبة بين الماء والإمام عليه السلام وما وجه العلاقة؟
قلت : كما أنّ الماء سبب الحياة ؛ كما قال :( وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ ) (٣) كذلك الإمام عليه السلام سبب لحياة كلّ مخلوق ظاهرا وباطنا، وكثيرا ما يعبّر عن العلم بالماء ؛ إذ به تحيا القلوب، كما أنّ موتها بالجهل، ولذا قال :
__________________
(١) تفسير القمّيّ ٢ : ٣٧٩.
(٢) كمال الدين ١ : ٣٢٥.
(٣) الأنبياء : ٣٠.
فالناس موتى وأهل العلم أحياء(١)
وحكي أنّ فلسفيّا خبيثا تليت عنده هذه الآية فقال : نأتي حينئذ بالماء بمعاونة الفؤوس والمعاول، يعني بحفر الآبار، فذهب ماء عينيه فصار أعمى لا يبصر شيئا، فقيل له : ائت بماء عينك بالفؤوس والمعاول. وقد نظم المولويّ هذه القصّة في مثنويّه، وأشار إليها الزمخشريّ في كشّافه.
ومن المحتمل أن يراد بالماء : الروح، فيكون المعنى : إن أصبحت أرواحكم غائبة عن أبدانكم فمن يقدر على إرجاعها إلى أبدانكم؟ كما قال :( فَلَوْ لا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ * تَرْجِعُونَها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ) (٢) .
ومن المحتمل أن يراد به النفس الناطقة الّتي هي ملاك الإنسانيّة، ومنشأ العلم والمعرفة، فيكون المعنى : إن أصبحتم مسوخا فمن يقدر على تبديل صوركم إلى صورة الإنسان، وقلب حقيقتكم الناهقيّة إلى الفطرة الإنسانيّة.
وبعبارة أخرى : لو قال لكم مثلا «كونوا قردة خاسئين» كما قال لجماعة من بني إسرائيل فمن يقدر على تبديل ذلك؟! فكيف لا تشكرون ولا تؤمنون؟
ومن المحتمل أن يراد به نفس الوجود، فيكون المعنى : إن ردّكم إلى ما كنتم عليه من العدم ؛ كما أخبر عنكم بقوله :( هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً ) (٣) وسلبكم نعمة الوجود، فهل يقدر أحد على إيجادكم وإيتائكم السمع والبصر والفؤاد؟! فكيف لا تشكرون نعمة الوجود الّتي هي أصل كلّ فيض وجود؟ وكيف تتّخذون من دونه آلهة تعبدون!
__________________
(١) ديوان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : ٢٤. وأوّل البيت : ففز بعلم ولا ترضى به بدلا
(٢) الواقعة : ٨٦ ـ ٨٧.
(٣) الإنسان : ١.
درّة الدرر في تفسير
سورة الكوثر
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[المقدّمة]
الحمد لله الّذي أعطى محمّدا وآله الأكرمين ما لم يعط أحدا من العالمين ؛ فجعلهم حججا على جميع أهل السماوات والأرضين والصلاة عليهم وعلى شيعتهم الأكملين، ولعنة الله على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى يوم الدين.
أمّا بعد، فيقول الفقير إلى الله ابن علي مدد حبيب الله : إنّ هذه عجالة سمّيناها بـ «درّة الدرر» كتبناها تفسيرا لسورة الكوثر، إجابة لملتمس بعض الإخوان من أهل الإيقان، وبالله المستعان وعليه التكلان.
قال الله تعالى سبحانه :( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) بدأ الملك الوهّاب في هذا الخطاب كسائر الكتاب المستطاب(١) بالبسملة المشتملة على اسمي الذات والصفات، تعليما لعباده وإرشادا لهم إلى أنّه ينبغي لهم أن يبدأوا في جميع أمورهم بهذه الكلمة ليتمّ لهم المقاصد، ويكمل لهم المصادر
__________________
(١) إشارة إلى ما عليه المصنّف رحمه الله وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم من جزئيّة البسملة في كلّ سورة عدا سورة براءة، وقد أشبع البحث عنها في «منتقد المنافع في شرح المختصر النافع» ٤ : ٣٥٤ من المطبوع على صورة خطّه الشريف.
والموارد(١) ، فيكون التقدير : يا عبادي قولوا : بسم الله إلى آخره، أو للإرشاد إلى أنّ اسمه وصفته أوّل الأسماء والصفات وفي هذه الكلمة إشارات لمن يتنبّه لها سوى أهل البشارات.
وفي العرائس : إنّ الباء كشف البقاء لأهل الفناء، والسين كشف سناء القدس لأهل الأنس، والميم كشف الملكوت لأهل النعوت
وقال أيضا : إنّ الباء بدو العبوديّة، والسين سرّ الربوبيّة، والميم منّه في أزليّته على أهل الصفوة(٢) . انتهى.
وفي تفسير الصادق عليه السلام : إنّ الباء بهاء الله، والسين سناء الله، والميم ملك الله ؛ والله إله كلّ شيء.
والرحمن بجميع خلقه، والرحيم بالمؤمنين خاصّة(٣) . انتهى.
وقيل : إنّ بسم الله كلمة سالبة للقلوب، رافعة للكروب، ساترة للعيوب، مظهرة للغيوب.
وحكى أبو البقاء عن البوصريّ أنّ بعض النصارى استدلّ على مذهبه من أنّ المسيح هو ابن الله بأنّه يظهر من تكسير حروف البسملة هذه العبارة : المسيح عليه السلام هو ابن الله المحرّر. قال : قال : فقلت له : فحيث رضيت
__________________
(١) يمكن أن يكون إشارة إلى حديث التسمية المعروف المرويّ عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وهو : «كلّ أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر» راجع البحار ٧٣ : ٣٠٥ ونقله المصنّف رحمه الله في تفسير سورة الفاتحة : ٤ من المخطوط أيضا، تفسير الصافي ١ : ٥٢.
(٢) عرائس البيان في حقائق القرآن : ٤.
(٣) تفسير القمّيّ ١ : ٢٨. وليعلم أنّ في صحّة انتساب ما هو الموجود بأيدينا بعنوان تفسير القمّيّ للشيخ أبي الحسن عليّ بن إبراهيم القمّيّ رحمه الله بحثا ليس هنا موضعه فراجع مشايخ الثقات للشيخ غلامرضا عرفانيان «طبع قم» الحلقة الأولى : ٢٠ ذيل الصفحة.
البسملة بيننا وبينك حكما وجوّزت منها أحكاما فلتنصرنّ البسملة الأخيار منّا على الأشرار ولتفضّلنّ أصحاب الجنّة على أصحاب النار، وقالت لك البسملة بلسان حالها : إنّما الله ربّ للمسيح راحم، النحر لامم لها المسيح ربّ، ما برح الله راحم للمسلمين، سل ابن مريم أحلّ له الحرام، لا المسيح ابن الله محرّر، لا مرحم للئام أبناء السحرة. رحم حرّ مسلم أناب إلى الله، لله نبيّ مسلم حرّم الرّاح، الحلم ربح رأس ماله الإيمان إلى أن قال : ثمّ انظر إلى البسملة قد تخبر أنّ من وراء حولها خيولا وليوثا، من دون طلّها سيولا وغيوثا. ولا تحسبنّي استحسنت كلمتك الباردة فنسجت على منوالها، وقابلت الواحدة بعشر أمثالها، بل أتيتك بما يبغيك فيبهتك، ويسمعك ما يصمّك عن الإجابة ويصمتك، فتعلم به أنّ هذه البسملة مستقرّ لسائر العلوم والفنون، ومستودع لجوهر سرّها المكنون، ألا ترى أنّ البسملة إذا حصلت جملتها كان عددها سبعمائة وستّة وثمانين فوافق جملها مثل عيسى كآدم ليس لله شريك بحساب الألف الّتي بعد لامي الجلالة، ولا أشرك به أحدا يهدي الله لنوره من يشاء بإسقاط ألف الجلالة، فقد أجابتك البسملة بما لم يحط به جزء، وجاءتك بما لم تستطع عليه صبرا(١) إلى آخره.
ولا يخفى أنّ ما استخرجه النصرانيّ والبوصريّ لا يوافق شيئا من التكسيرين المعروفين بين أهل الجفر ؛ أعني التكسير بالصدر المؤخّر والتكسير بالصدر المقدّم(٢) ، ولعلّ ذلك بموافقة الحروف أو بنحو آخر من
__________________
(١) كتاب الكليات، لأبي البقاء الحسينيّ الكفويّ : ٦ ـ ٧ بالطبع الحجريّ ط ايران ١٢٨٦ ق.
(٢) بيان مسألة التكسير المصطلح في الجفر موجود في كشّاف اصطلاحات الفنون ١ : ١٨٣ كلمة
أنحاء التكسير فتدبّر. وقد استخرجنا من البسملة كلمات أخر أشرنا إليها في تفسير سورة الفاتحة(١) ، وكذا إلى جملة من فضائلها وخواصّها وإلى أدلّة جزئيّتها لكلّ سورة.
قال سبحانه :( إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ ) التصدير بكلمة التحقيق للدلالة على أنّ المذكور بعدها ممّا له تحقّق وثبوت في نفس الأمر، بحيث لا مجال لاعتراء الارتياب فيه والإنكار عليه، والمخاطب بهذا الخطاب ليس منكرا حتّى يجب التأكيد، ولا متردّدا حتّى يستحسن، ولا منزلا منزلة أحدهما. فانحصرت الفائدة في ذكرها فيما ذكرناه مع أنّ فيه تحسينا للكلام.
وقد صرّح التفتازانيّ بأنّه لا تنحصر فائدة إنّ في تأكيد الحكم نفيا لشكّ أو ردّا لإنكار، قال : ولا يجب في كلّ كلام مؤكّد أن يكون الغرض منه ردّ إنكار محقّق أو مقدّر(٢) . انتهى.
وفي التعبير بإنّا دون إنّي دلالة على إظهار العظمة والكبرياء، وقد جرت عادة السلاطين والعظماء على التعبير عن أنفسهم بما يعبّر به عن الجمع تصدر إلى ما ذكر من إظهار العظمة، وكذا جرت العادة في مخاطبة العظماء والإخبار عنهم، بل ربّما ينادى الواحد بنداء الجمع لذلك أو للإشارة إلى أنّه
__________________
«البسط» فراجع، أيضا : راجع كلمة التكسير منه. طبع مكتبة النهضة المصريّة. أيضا راجع : منتخب قواميس الدرر للمؤلّف رحمه الله : ٣٧.
(١) اسمه «الأنوار السانحة في تفسير سورة الفاتحة» موجود ضمن هذه المجموعة. فراجع. وقد ذكر المصنّف رحمه الله في آخره أنّ هذه الرسالة كتبها قبل زمان بلوغه. وهو لا شكّ من بالغ عنايات ربّه.
(٢) كتاب المطوّل «أحوال الإسناد الخبريّ» الطبع الحجريّ بخطّ عبد الرحيم : ٤٢ والطبع الحديث بحاشية السيد مير شرى : ٥٣.
مستجمع لجميع مراتبهم وكمالاتهم ؛ كما في قوله تعالى مخاطبا لنبيّنا صلّى الله عليه وآله :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ) (١) إلى آخره.
فإذا جاز هذا التعبير بالنسبة إلى من عظمته موهومة اعتباريّة(٢) أو إضافيّة، فكيف لا يجوز بالنسبة إلى من عظمته حقيقيّة سرمديّة كبريائيّة مطلقة أبديّة وأزليّة؟! فهو العظيم فوق كلّ عظيم، لا يشاركه في عظمته شيء، ولا يدانيه في كبريائه أحد من العالمين.
وفيه أيضا إشارة إلى تعظيم المعطى له، فإنّ العظيم لا يخاطب غالبا إلّا العظيم اللائق لمخاطبته ومكالمته، وإلى تعظيم المعطى أي العطيّة، فكما «أنّ الهدايا على مقدار مهديها» فكذلك العطايا على مقدار معطيها، وأمّا تقدّم المعطى له على المعطى مع أنّه المقصود الأهمّ في هذا المقام، فلأمر لفظيّ، وسرّ لبّيّ.
أمّا الأوّل، فلأنّ المعطى له وإن كان مفعولا أوّلا للإعطاء ولكنّه فاعل بحسب المعنى حيث إنّه في تأويل الأخذ كما أنّ المعطى الّذي هو المفعول الثاني بتأويل المأخوذ والأصل سبق المفعول الّذي هو الفاعل بحسب المعنى على المفعول الّذي ليس بهذه(٣) المثابة كما في «كسوت زيدا جبّة»
__________________
(١) البقرة : ١٧٢.
(٢) الاعتباريّ من المفاهيم ما ليس بإزائه خارج، وربّما يطلق عليه الانتزاعيّ أيضا، والإضافي هنا بمعنى ما كانت شيئيّته منسوبة ومضافة إلى الغير، مأخوذ ممّا يصطلح عليه في الحكمة بالإضافة الإشراقيّة، م.
(٣) قال ابن مالك في الألفيّة
والأصل سبق فاعل معنى كمن |
من ألبسن من زاركم نسج اليمن |
راجع بحث رتب المفاعيل من البهجة المرضية الطبع الحجريّ بخطّ عبد الرحيم.
فقدّم زيدا لكونه الكاسي، هذا مع أنّ في التأخير يلزم انفصال الضمير مع تيسّر اتّصاله، والغرض من وضع الضمير الاختصار، وهو مناف للانفصال في الجملة.
أمّا الثاني، فلأنّ الأشياء وإن كان جميعها مفاعيل للحقّ المطلق لأنّه خالقها ومبدعها ومكوّنها ومصوّرها إلّا أنّ محمّدا صلّى الله عليه وآله المخاطب بهذا الخطاب المعطى له هذا العطاء المستطاب هو مفعوله الأوّل بلا واسطة شيء آخر ؛ إذ شيئيّة كلّ شيء إنّما هي بعد شيئيّته صلّى الله عليه وآله المستفادة من شيئيّة الحقّ الأوّل تعالى، فهو صلّى الله عليه وآله في أعلى مراتب القرب إليه تعالى المعبّر عنه بالوصل والاتّصال، فكلّ واصل إلى الحقّ لا يكون وصله إلّا بواسطته، فله صلّى الله عليه وآله تمام الوصل من دون أن يفرّق بينه وبينه بشيء.
قال الله سبحانه :( إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ ) إلى قوله تعالى( أُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ حَقًّا ) (١) إلى آخره.
وليس مرادنا بالوصل الوصل الحسّيّ نظير اتّصال الشعاع بالشمس أو السراج، ولا الاتّحاد الّذي يزعمه بعض الصوفيّة من قبيل اتّحاد القطرة مع البحر، لأنّ الممكن الحادث لا يتّصل بالواجب القديم ولا يتّحد معه، فإنّ كنهه تعالى تفريق بينه وبين خلقه كما في الحديث، فهو منزّه عن الوصل والفصل، بل المراد تمام القرب إلى ساحة حضرته بالقرب المعنويّ لا المكانيّ الّذي هو من خواصّ الجسم والجسمانيّ. وعليه يحمل ما قاله
__________________
(١) النساء : ١٥٠ و ١٥١.
بعض العارفين من أنّ لله شرابا طاهرا صافيا ادّخره في كنوز ربوبيّته سقاه أولياءه في ميدان كرامته بكأس هنيئة على منابر عزّه، فإذا شربوا سكروا، وإذا سكروا طاشوا، وإذا طاشوا اشتاقوا، وإذا اشتاقوا طاروا، وإذا طاروا بلغوا، وإذا بلغوا وصلوا، وإذا وصلوا اتّصلوا، وإذا اتّصلوا فنوا، وإذا فنوا بقوا، وإذا بقوا صاروا ملوكا وسادة وأحرارا وقادة. انتهى.
وقريب منه ما روي من أنّ لله شرابا لأوليائه إذا شربوا سكروا، وإذا سكروا طربوا، وإذا طربوا طلبوا، وإذا طلبوا وجدوا، وإذا وجدوا وصلوا، وإذا وصلوا اتّصلوا، وإذا اتّصلوا فلا فرق بينهم وبين حبيبهم. انتهى. إلّا أنّي لم أجد هذه الرواية في كتاب معتمد عليه(١) .
وكيف كان فلعلّ وصل الضمير في المقام وتقديمه على العطيّة إشارة إلى كمال قرب المخاطب ومظهريّته لتمام أسماء الحقّ وصفاته كما يرشد إليه قوله تعالى :( وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللهَ رَمى ) وقوله :( إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللهَ ) وغير ذلك فافهم.
__________________
(١) نقله المحدّث الكاشانيّ رحمه الله في «كلمات مكنونه» عن كتاب ابن جمهور «كذا» الإحسائيّ عن أمير المؤمنين عليه السلام. والصحيح ابن أبي جمهور وفي اعتبار كتابه بحث فراجع : الذريعة إلى تصانيف الشيعة ١٥ : ٣٥٨ و ١٦ : ٧١ وانظر تفصيل البحث في خاتمة المستدرك : ٣٦١ ـ ٣٦٥ «مستدرك الوسائل ٣» المطبوع على الحجر، والحديث في «كلمات مكنونه» طبع ايران ١٣٨٣ ق بتصحيح فضيلة الشيخ عزيز الله عطاردي القوچانيّ : ٧٩ وطبع بمبئي ١٢٩٦ ق : ٧٧. وأيضا أورده السيّد حيدر الآمليّ رحمه الله في مواضع من كتابه «جامع الأسرار ومنبع الأنوار» انظر : ٢٠٥ و ٣٦٣ و: ٣٨١ ورسالة نقد النقود الملحق به : ٦٧٦. وأورده النراقيّ أيضا في جامع السعادات ٣ : ١٥٣ والمؤلّف رحمه الله في «أسرار حسينيّة» طبع ١٣٨٠ ق صفحة ٤٧ ومن الطبع الجديد : ٢١.
وفي بعض القراءات(١) : «إنّا أنطيناك» بإبدال العين نونا. ونسبه في الكشّاف(٢) إلى قراءة رسول الله صلّى الله عليه وآله من الإنطاء وهو الإعطاء.
قال ابن الأثير في نهايته : وفي حديث الدعاء «لا مانع لمن أنطيت، ولا منطي لما منعت» وهي لغة أهل اليمن في أعطى، ومنه الحديث : اليد المنطية خير من اليد السفلى، ومنه كتابه لوائل(٣) «وأنطوا الثبجة»(٤) انتهى. بالثاء المثلّثة بعدها الباء الموحّدة ثمّ الجيم وهي الوسط أي : أعطوا الوسط في الصدقة لا من خيار المال ولا من رذالته. كذا في النهاية(٥) أيضا.
والكوثر : فوعل من الكثير، ولمّا كان كثرة المباني دالّة على كثرة المعاني(٦) على ما ذكره جماعة، فهو في اللغة بمعنى الخير المفرط الكثير كما في الكشّاف، قال :
قيل لأعرابيّة رجع ابنها من السفر، بم آب ابنك؟ قالت : آب بكوثر قال :
وأنت كثير يا ابن مروان طيّب |
وكان أبوك ابن العقائل كوثرا(٧) |
__________________
(١) والقاري : الحسن وطلحة وابن محيص والزعفرانيّ وأمّ سلمة على ما نقل. انظر : معجم القراءات القرآنيّة ٨ : ٢٥٣، وروح المعاني ٣٠ : ٢٤٤.
(٢) الكشّاف ٤ : ٢٩٠.
(٣) وفي المصدر : وائل بن حجر.
(٤) النهاية في غريب الحديث والأثر ٥ : ٧٦.
(٥) النهاية في غريب الحديث والأثر ١ : ٢٠٦.
(٦) هذا تعليل لا أصل له إن كان على إطلاقه وكلّيته. انظر تفصيل البحث في البيان في تفسير القرآن للسيّد الخوئيّ رحمه الله ٤٦٦.
(٧) الكشّاف ٤ : ٢٩٠ ونسب البيت في تفسير القرطبيّ «الجامع لأحكام القرآن» ٢٠ : ٢١٦، والآلوسيّ في «روح المعاني» ١٠ : ٢٤٥ إلى الكميت.
وفي القاموس : الكوثر : الكثير من كلّ شيء، والكثير الملتفّ من الغبار والإسلام والنبوّة، وقرية من الطائف كان الحجّاج معلّما بها، والرجل الخيّر المعطاء كالكيثر كصيقل والسيّد والنهر ونهر في الجنّة تتفجّر منه جميع أنهارها. انتهى(١) .
وفسّر الكوثر في هذه الآية بوجوه كثيرة :
منها : أنّ المراد به استغراقه في بحر جماله ودنوّه في منازل قربه. ذكره صاحب عرائس البيان في تفسير حقائق القرآن(٢) .
ومنها : أنّ المراد به كوثر القلب تجري فيه أنهار أنوار مشاهدة الحقّ من بحار الأزل والأبد، يزيد في كلّ نفس سرايتها إلى الأبد(٣) . قاله في العرائس أيضا.
ومنها : أنّ المراد : إنّا أعطيناك نورا في قلبك دلّك عليّ وقطعك عمّا سواي. حكاه عن جعفر عليه السلام.
ومنها : أنّ المراد الشفاعة للامّة. حكاه عنه أيضا.
ومنها : أنّ المراد به الرسالة والنبوّة. حكاه عن ابن عطاء.
ومنها : أنّ المراد إنّا أعطيناك معرفة بربوبيّتي وانفراد الوحدانيّة. حكاه عنه أيضا(٤) .
ومنها : أنّ المراد به الولاية المطلقة الكلّيّة الجامعة لتمام مراتب
__________________
(١) القاموس المحيط ٢ : ١٢٥.
(٢) عرائس البيان : ٣٨٥.
(٣) المصدر نفسه.
(٤) عرائس البيان : ٣٨٥.
الكمال المستعلية للإنسان الّذي هو جوهر الأكوان، وأنموذج عوالم الإمكان، ومن فروعها النبوّة والرسالة، فإنّ هذه المرتبة لم ينلها سواه ولم يعطها الله غيره. ولذا كانت نبوّته حقيقيّة دائميّة باقية إلى يوم القيامة بخلاف سائر النبوّات، والسرّ في ذلك على ما ذكره الغزاليّ في كتابه المسمّى بكشف الوجوه الغرّ(١) : إنّ النبوّة بمعنى الإنباء، والنبيّ هو المنبئ عن ذات الله وصفاته وأسمائه وأحكامه ومراداته، والإنباء الحقيقيّ الذاتيّ ليس إلّا للروح الأعظم الّذي بعثه الله إلى النفس الكلّيّة أوّلا، ثمّ إلى النفوس الجزئيّة ثانيا، لينبّئهم بلسانه العقليّ عن الذات الأحديّة، والصفات الأزليّة، والأسماء الإلهيّة، وكلّ نبيّ من آدم عليه السلام إلى محمّد صلّى الله عليه وآله مظهر من مظاهر نبوّة الروح الأعظم، فنبوّته ذاتيّة دائمة، ونبوّة المظاهر عرضيّة ومنصرمة إلّا نبوّة محمّد صلّى الله عليه وآله فإنّها دائمة غير منصرمة ؛ إذ
__________________
(١) نسبة الكتاب إلى الغزاليّ سهو من قلم المصنّف رحمه الله قد صدر هنا وفي بعض آخر من مصنّفاته كتفسير سورة الفاتحة : ٧ من المخطوط، هذا وكتاب كشف الغرّ على ما هو المعروف من مؤلّفات الشيخ عبد الرزّاق الكاشانيّ المتوفّى سنة ٧٣٦ ق، وهو شرح على التائيّة الكبرى المعروفة لابن الفارض وهو مطبوع على الحجر بطهران في سنة ١٣١٩ ق مع شرح الفصوص للفارابيّ «تعليقات نفحات الأنس للدكتور محمود عابدي : ٨٧١». وأيضا طبع في هامش ديوان ابن الفارض في مصر ١٣١٩ كما في الذريعة ١٨ : ٦٧ كما أنّه طبع ضمن نتائج الأفكار القدسيّة للعروسيّ «راجع مقدّمة الدكتور محمّد كمال إبراهيم جعفر على اصطلاحات الصوفيّة للقاشانيّ ـ انتشارات بيدار : ٧» بينما أنّ بعض الأفاضل «كالأستاذ الفقيد جلال الدين همائي» مصرّ على خطأ هذه النسبة وأنّه من مؤلّفات عزّ الدين محمود الكاشانيّ المتوفّى سنة ٧٣٥ ق «المعاصر للشيخ عبد الرزّاق المذكور» راجع مقدّمة مصباح الهداية ومفتاح الكفاية : ١٦ وأيضا مقدّمة شرح منازل السائرين : ٢٩ ومقدّمة تحفة الإخوان في خصائص الفتيان لكمال الدين عبد الرزّاق الكاشانيّ رحمه الله بقلم الدكتور سيّد محمّد دامادي : ١٥.
حقيقته حقيقة الروح الأعظم في صورته ؛ الصورة الّتي ظهر فيها الحقيقة بجميع أسمائها وصفاتها وسائر الأنبياء مظاهرها ببعض الأسماء والصفات، تجلّت في كلّ مظهر بصفة من صفاتها إلى أن تجلّت في المظهر المحمّديّ صلّى الله عليه وآله بذاتها وجميع صفاتها، وختم به النبوّة فكان الرسول سابقا على جميع الأنبياء من حيث الحقيقة، متأخّرا عنهم من حيث الصورة كما قال : نحن الآخرون السابقون.
وقال صلّى الله عليه وآله : «كنت نبيّا وآدم بين الماء والطين»(١) وفي رواية : «بين الروح والجسد»(٢) انتهى
ولعلّ من فسّر الكوثر بالنبوّة أراد خصوص هذه النبوّة، لأنّ المقام مقام الامتنان، ولا اختصاص لمطلق النبوّة به، وإنّما المختصّ به صلّى الله عليه وآله مقام النبوّة المطلقة الّتي باطنها الولاية الكلّيّة فافهم واغتنم وكن من الشاكرين. وإلى هذا التفسير يرجع تفسير الكوثر بعليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه، لكونه مظهرا لمقام ولاية محمّد صلّى الله عليه وآله الكلّيّة الّتي هي العلّة الغائيّة لخلق الموجودات الإمكانيّة. ومن هنا ينكشف سرّ قوله : «لولاك لما خلقت الأفلاك، ولو لا عليّ لما خلقتك» وقد أوضحنا ذلك في كتاب الأربعين.
ومنها : العلم والعمل اللّذان هما جناحا الروح للطيران إلى معارج القدس، والارتقاء إلى مدارج الأنس، وهما ركنا العبوديّة الّتي هي جوهرة كنهها الربوبيّة.
__________________
(١) المناقب، لابن شهر آشوب ١ : ٢١٤.
(٢) سنن الترمذيّ ٥ : ٥٨٥، كشف الوجوه الغرّ : ١٦٤ وقد سبق الخلاف في مؤلّفه فراجع.
ومنها : الصيت بكسر الصاد وسكون الياء، وهو حسن الذكر واشتهاره وإشادته. وقد اشتهر ذكره على الألسن في جميع البلاد في مدّة قليلة، قال الله :( وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ ) . قال الطبرسيّ رحمه الله : أي قرنّا ذكرك بذكرنا حتّى لا أذكر إلا وتذكر معي يعني في الأذان والإقامة والتشهّد والخطبة والمنابر.
وحكى عن قتادة أنّه قال : أي رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، وليس خطيب ولا متشهّد ولا صاحب صلاة إلّا وينادي بـ «أشهد أن لا إله إلّا الله، وأشهد أنّ محمّدا رسول الله»(١) .
ومنها : القرآن المجيد لكثرة ما فيه من العلوم والحكم والأسرار، بل( وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ ) (٢) .
قال الصادق عليه السلام : «ولدني رسول الله وأنا أعلم كتاب الله و... فيه بدء الخلق وما هو كائن إلى يوم القيامة وفيه خبر السماء، وخبر الأرض، وخبر الجنّة والنار، وخبر ما كان، وما هو كائن، أعلم ذلك كما أنظر إلى كفّي، إنّ الله يقول : فيه تبيان كلّ شيء»(٣) انتهى.
فالكوثر من أسماء القرآن، وقد عبّر الله عنه في كتابه بأسام كثيرة كالذكر والتنزيل والفرقان وغيرها.
__________________
(١) مجمع البيان ١٠ : ٥٠٨.
(٢) من المقطوع به أن ليس المراد بكتاب مبين هو القرآن كما صرّح به الأستاذ الشهيد «المطهريّ» رحمه الله في كتابه القيم «انسان وسرنوشت» : ٩، وأيضا راجع : مجمع البيان ٤ : ٣١١، والميزان ٧ : ١٢٨.
(٣) الكافي ١ : ٦١ باب الردّ إلى الكتاب والسنّة الحديث ٨. والآية الكريمة في سورة النحل : ٨٩( وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ ) .
ومنها : الخير الكثير كما هو أحد معانيه لغة كما عرفته، ولعلّ المراد به أكمل الوجود في ساحة الشهود، فإنّه منه كلّ خير وجود، كما أنّ في العدم كلّ شرّ وكنود، قد ترتّب على وجوده الكامل آثار كثيرة لم يترتّب على غيره من أفراد الموجود ممّا خرج عن خزائن الجود بل هو فاتحة كتاب الوجود، وخاتمة دائرة الموجود.
ومنها : كثرة النسل والذرّيّة، فإنّه قد ظهرت الكثرة في نسله من ولد فاطمة عليها السلام حتّى لا يحصى عددهم، واتصل إلى يوم القيامة مددهم، ولعلّ هذا أيضا مراد من فسّر الكوثر بها.
ومنها : خصوص الذرّيّة الطيّبة والأئمّة المعصومين من آله ؛ الّذين جعلهم الله أمناءه في خلقه، وخلفاءه في سمائه وأرضه.
ومنها : كثرة الأصحاب والأشياع والأمّة ؛ ولذا قال صلّى الله عليه وآله : «تناكحوا تناسلوا تكثروا فإنّي أباهي بكم الأمم يوم القيامة»(١) .
وقد قال الباقر عليه السلام : إنّ الناس صفوف عشرون ومائة ألف صفّ ؛ ثمانون ألف صفّ صفّ أمّة محمّد صلّى الله عليه وآله، وأربعون ألف صفّ من سائر الأمم(٢) .
ومنها : شرف الدارين ؛ أمّا في الدنيا فلمقام نبوّته المطلقة، ورسالته العامّة، وأمّا في الآخرة فلشفاعته الكلّيّة.
__________________
(١) مستدرك الوسائل ٢ : ٥٣١، ومن الطبعة الحديثة ١٤ : ١٥٣.
(٢) الكافي ٢ : ٥٩٦ كتاب فصل القرآن، الحديث ١٤ والأصل والناس صفوف مكان «إنّ الناس».
وما ورد من أنّها لولده الحسين عليه السلام(١) فلا ينافي ذلك، فإنّه عليه السلام منه صلّى الله عليه وآله وهو صلّى الله عليه وآله منه عليه السلام كما نصّ عليه في الحديث المشهور المتّفق عليه بين الفريقين(٢) ، فشفاعة الحسين عليه السلام في شفاعته صلّى الله عليه وآله وبالجملة الشرافة الحقيقيّة بمجامعها وحذافيرها لنبيّنا صلّى الله عليه وآله خاصّة، وكلّ شرف في غيره فهو من متابعته ومودّته، قال عليه السلام في الزيارة الجامعة : «آتاكم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين، طأطأ كلّ شريف لشرفكم، وبخع كلّ متكبّر لطاعتكم ...» إلى آخره. قال بعض شرّاحها : طأطأ رأسه إذا طامنه وخفضه. والشرف : العلوّ والمكان العالي الحسّيّ كما في الحديث : «كان يكبّر على شرف من الأرض»(٣) والمعنويّ ومنه يسمّى الرجل العالي المقام والمكانة شريفا لعلوّ رتبته، وقد يقال لمن نال شيئا لم ينله بعض أمثاله من الناس حتّى إنّه ليقال لصاحب المال المتموّل والمتملّك شريفا.
وروي في الحديث : «إذا أتاكم شريف قوم فأكرموه ؛ سئل ما الشريف؟
__________________
(١) لم أجد إلى الآن ما يدلّ ظاهرا على انحصار الشفاعة لأبي عبد الله الحسين عليه السلام سوى ما ورد ضمن حديث الكساء وهو : «... السلام عليك يا ولدي ويا شافع أمّتي ...» فراجع.
(٢) احقاق الحقّ ١١ : ٢٧٩ ـ ٢٦٥.
(٣) في الكافي ٢ : ٣١٨ في حديث فقام عيسى عليه السلام بالليل على شرف من الأرض وفي مرآة العقول ١٠ : ٢٣٨ قال الشيخ البهائيّ قدّس سرّه : الشرف : المكان العالي، قيل : ومنه سمّي الشريف شريفا تشبيها للعلوّ المعنويّ بالعلوّ المكانيّ راجع أيضا : «الأربعين» للشيخ البهائيّ رحمه الله : ١٣٥.
فقال : الشريف من كان له مال»(١) لأنّه عالي الرتبة بين من لم يملك مثله من المال، ولا يختصّ بأمر، بل كلّ من فاق بعض أبناء جنسه في شيء فهو شريف، فقد شرّفه الله تشريفا علّاه ورفع درجته.
وقد يفرّق بينه وبين الحسب، فإنّ الحسب : الشرف من قبل الآباء، أي لآبائه شرف ومراتب عالية، وشرف الرجل من نفسه إلى أن قال : ولزم من جميع ذلك أن يطأطئ كلّ شريف لشرفهم ؛ إذ ليس في الكون ممّا خلق الله شريف يفوقهم أو يساويهم، بل كلّ من سواهم معلول لهم(٢) إلى آخره.
ومنها : أنّ المراد به نهر في الجنّة إعطاء الله لرسوله صلّى الله عليه وآله عوضا عن ابنه إبراهيم. كذا في التفسير الصادقيّ عليه السلام(٣) .
ومنها : أنّ المراد به هو حوض النبيّ صلّى الله عليه وآله في عرصات المحشر، والظاهر أنّه غير النهر الّذي أشرنا إليه، لتصريح بعض الأخبار بأنّه في الجنّة، وأنّه نهر يتفجّر منه جميع أنهار الجنّة.
وعن ابن عبّاس قال : لمـــّـا نزل( إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ ) صعد رسول الله صلّى الله عليه وآله المنبر فقرأها على الناس، فلمّا نزل قال : يا رسول الله، ما هذا الّذي أعطاك؟ قال : نهر في الجنّة أشدّ بياضا من اللبن، وأشدّ استقامة من القدح، حافتاه قباب الدرّ والياقوت، ترده طير خضر لها أعناق كأعناق البخت، قالوا : يا رسول الله، ما أنعم تلك الطير! قال : أفلا أخبركم بأنعم
__________________
(١) صدر الحديث في مستدرك الوسائل ٨ : ٣٩٧ الحديث رقم ٩٧٨٤ مع ذيل آخر، ومن طبعه القديم ٢ : ٧٤ عن المحاسن : ٣٢٨ الحديث رقم ٨٤.
(٢) شرح الزيارة، للشيخ أحمد الإحسائيّ المطبوع على الحجر، تبريز سنة ١٢٧٦ صفحة ٣٥٤.
(٣) تفسير نور الثقلين ٥ : ٦٨٠ عن مجمع البيان ١٠ : ٥٤٩، أيضا تفسير عليّ بن إبراهيم ٢ : ٤٤٥.
منها؟ قالوا : بلى، قال : من أكل الطائر وشرب الماء فاز برضوان الله(١) .
وفي رواية أنّه صلّى الله عليه وآله قال : إنّه نهر في الجنّة وعدنيه ربّي ؛ فيه خير كثير(٢) انتهى.
وفي رواية أخرى : أنّه أحلى من العسل، وأشدّ بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج، وألين من الزبد ؛ حافتاه الزبرجد، وأوانيه من فضّة عدد نجوم السماء(٣) .
وفي ثالث : أنّه من شرب منه لا يظمأ أبدا، وأنّ أوّل وارد به فقراء المهاجرين الدنسو الثياب، الشعث الرؤوس، الّذين لا يزوّجون المنعّمات، ولا يفتح أبواب الدور، يموت أحدهم وحاجته تتلجلج في صدره، لو أقسم على الله لأبرّه(٤) . انتهى.
وهذه الأخبار مصرّحة بأنّ هذا النهر في أصل الجنّة، والروايات الواردة في حوض(٥) النبيّ صلّى الله عليه وآله كاشفة عن أنّه في خارجها، وثبوت هذا الحوض له صلّى الله عليه وآله متّفق عليه بين الفريقين.
__________________
(١) المصدر عن المجمع أيضا.
(٢) تفسير روح البيان، الشيخ إسماعيل حقّي البروسويّ ١٠ : ٥٢٤.
(٣) المصدر نفسه : ٥٢٤، وأيضا بمضمونه في الدرّ المنثور للسيوطيّ ٦ : ٤٠١ ـ ٤٠٢. وفي الجامع لأحكام القرآن «تفسير القرطبيّ» ٢ : ٢١٧، وروح المعاني، للآلوسيّ البغداديّ ٣٠ : ٢٤٤ ـ ٢٤٥، وتفسير الصافي ٢ : ٨٥٧، وتفسير نور الثقلين ٥ : ٦٨٢، ومجمع البيان ١٠ : ٥٤٩.
(٤) تفسير روح البيان ١٠ : ٥٢٤، والكشّاف ٤ : ٢٩١، وفيهما : «لا تفتح لهم أبواب السدر» مكان «لا يفتح أبواب الدور».
(٥) ويفتح نهر من الكوثر إلى الحوض راجع : مسند أحمد بن حنبل ١ : ٣٩٩. والروايات في الحوض كثيرة جدّا، وذكرها خارج عن طور الرسالة.
وقد أشار إليه الحميريّ في قصيدته المعروفة بقوله :
وراية يقدمها حيدر |
ووجهه كالشمس إذ تطلع |
|
إمام صدق وله شيعة |
يرووا من الحوض ولم يمنع(١) |
وبعض علماء العامّة في منظومته قال :
قد أوتي المصطفى حوضا له عظم |
من خير ما قد أتاه الله للرّسل |
|
لا شكّ فيه كما صحّ الحديث به |
عن صدق وعد فيسقى كلّ ذي عمل |
|
أصفى بياضا من الألبان أجمعها |
من أعذب الماء بل أحلى من العسل |
|
يذاد عنه أناس لا خلاق لهم |
قد قابل الدين بالتغيير والبدل |
|
والحوض من بعد لا قبل الصراط أتى |
وقيل قبل وقيل اثنان فلتسلي |
فهذا الحوض ممّا يجب الإيمان به في الجملة ؛ كما يدلّ عليه كثير من الأخبار.
__________________
(١) بيتان من القصيدة المعروفة للسيّد الحميريّ أوّلها :
لامّ عمرو باللّوى مربع |
طامسة أعلامه بلقع |
وقد شرحهها العلماء رحمهم الله بشروح كثيرة، فراجع الذريعة إلى تصانيف الشيعة ١٤ : ٩ ـ ١١، وللمؤلّف رحمه الله أيضا شرح لطيف عليها موجود بخطّه الشريف، وقد طبع ضمن كتاب «منبع الفرائد» لحفيده الحاج السيّد عزيز الله إمامت الكاشانيّ من صفحة ٢٧٦ إلى ص ٣٥٧.
نعم، عن المعتزلة أنّ الحوض كناية عن اتّباع سنّة الرسول صلّى الله عليه وآله وهو كما ترى.
والمشهور أنّه في الموقف في أرض القيامة. وربّما يقال : إنّه خلف الصراط. وهو كما ترى.
ويمكن التوفيق بين التفسير السابق وهذا التفسير بأنّ الكوثر هو النهر الّذي في الجنّة ومنه ينصبّ الماء في هذا الحوض الّذي في أرض الموقف، كما ورد أنّه ينصبّ فيه ميزابا من الكوثر. فيجوز إطلاق الكوثر على هذا الحوض أيضا من هذه الجهة.
وكيف كان فقد روي في الأمالي عن ابن عبّاس أنّه قال : لمـــّـا نزل(١) على رسول الله صلّى الله عليه وآله :( إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ ) قال له عليّ بن أبي طالب عليه السلام : ما هو الكوثر يا رسول الله؟ قال : نهر أكرمني الله(٢) .
قال عليه السلام : إنّ هذا النهر(٣) شريف فانعته لنا. قال : [نعم، نهر](٤) يجري تحت عرش الله، ماؤه أشدّ بياضا من اللبن، [وأحلى من العسل](٥) وألين من الزبد ؛ حصاه الزبرجد والياقوت والمرجان، حشيشه الزعفران، ترابه المسك الأذفر(٦) ، قواعده تحت عرش الله. ثمّ ضرب رسول الله على
__________________
(١) في المصدر : نزلت.
(٢) في المصدر زيادة : به.
(٣) في المصدر : لنهر.
(٤) في المصدر : نعم يا عليّ، الكوثر نهر
(٥) أضفناه من المصدر.
(٦) الأذفر : شديد الرائحة.
جنب أمير المؤمنين وقال : يا عليّ : هذا النهر لي ولك ولمحبّيك من بعدي(١) .
وفي الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام : أنا مع رسول الله صلّى الله عليه وآله ومعي عترتي [وسبطيّ](٢) على الحوض إلى أن قال : نذود(٣) عنه أعداءنا، ونسقي(٤) أحبّاءنا وأولياءنا، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. حوضنا [مترع](٥) فيه مثعبان(٦) ينصبّان من الجنّة ؛ أحدهما من تسنيم، والآخر من معين، على حافتيه الزعفران، وحصاه اللؤلؤ [والياقوت](٧) وهو الكوثر(٨) . انتهى.
وفي رواية أبي أيّوب الأنصاريّ أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله سئل عن الحوض فقال : إنّ الحوض أكرمني الله به، وفضّلني على من كان قبلي من الأنبياء، وهو ما بين أيلة(٩) وصنعاء إلى أن قال : يذود عنه يوم القيامة من ليس من شيعته كما يذود الرجل البعير الأجرب من إبله، من شرب منه لا
__________________
(١) أمالي الشيخ الطوسيّ رحمه الله : ٦٩، وأمالي الشيخ المفيد رحمه الله : ٢٩٤.
(٢) أضفناه من المصدر.
(٣) في المصدر : فإنّا نذود.
(٤) في المصدر زيادة : منه.
(٥) أضفناه من المصدر.
(٦) المثعب : مسيل المياه.
(٧) أضفناه من المصدر.
(٨) الخصال : ٦٢٤.
(٩) أيلة «بالفتح» جبل بين مكّة والمدينة و... بلد بين ينبع ومصر، ومنه حديث حوض رسول الله صلّى الله عليه وآله : «عرضه ما بين صنعاء إلى أيلة» وإيلة بالكسر : قرية بين مددين وطور. مجمع البحرين ٥ : ٣١٥. وأيضا : راجع منتهى الإرب ١ : ٤٨.
يظمأ أبدا(١) . انتهى.
وفي رواية أنس قال : بينا رسول الله صلّى الله عليه وآله ذات يوم بين أظهرنا إذ غفا إغفاءة ثمّ رفع رأسه متبسّما فقلت : ما أضحكك يا رسول الله؟ قال : أنزلت عليّ آنفا سورة ؛ فقرأ سورة الكوثر، ثمّ قال : أتدرون ما الكوثر؟ قلنا : الله ورسوله أعلم، قال : فإنّه نهر وعدنيه عليه ربّي(٢) خيرا كثيرا، وهو حوض ترد عليه أمّتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء، فيختلج القرن منهم، فأقول : يا ربّ إنّهم من أمّتي؟ فيقال : إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك(٣) . انتهى.
أقول : لا منافاة بين التفسير بالنهر الواقع في الجنّة وبالحوض الواقع في العرصات كما عرفته، وكذا لا منافاة بين التفاسير المتقدّمة، حيث إنّها من أفراد الخير الكثير، فهو كلمة جامعة لتمام ما قيل في المقام، وإنّما الفرق بالإجمال والتفصيل. ويؤيّد ذلك ما في الكشّاف من أنّ ابن عبّاس(٤) فسّر الكوثر بالخير الكثير، فقال له سعيد بن جبير : إنّ ناسا يقولون : هو نهر في الجنّة؟ فقال : هو من الخير الكثير(٥) . انتهى.
ومن هنا قال الطبرسيّ رحمه الله في مجمع البيان : واللفظ يحتمل للكلّ، فيجب أن يحمل على جميع ما ذكرنا من الأقوال، فقد أعطاه سبحانه
__________________
(١) بحار الأنوار ٨ : ٢١، أمالي الشيخ الطوسيّ رحمه الله : ٢٢٨.
(٢) في المصدر : ربّي عليه.
(٣) مجمع البيان ١٠ : ٥٤٩، وأيضا راجع : مسند أحمد بن حنبل ٣ : ١٠٢.
(٤) راجع تنوير المقباس في تفسير ابن عبّاس ؛ المطبوع بهامش الدرّ المنثور ٦ : ٤٠٠.
(٥) الكشّاف ٤ : ٢٩١.
الخير الكثير في الدنيا، ووعده الخير الكثير في الآخرة، وجميع هذه الأقوال تفصيل للجملة الّتي هي الخير الكثير في الدارين(١) . انتهى.
هذا إلّا أنّ الظاهر إرادة كلّ من هؤلاء خصوص كلّ من هذه المعاني على انفراد، فالحمل على الجميع مستلزم لاستعمال اللفظة الواحدة في أكثر من معنى واحد، فتدبّر.
وللقائل بتجسّم الأعمال ـ كما هو ظاهر جملة من الآيات والروايات ـ أن يقول : إنّ المعاني المذكورة تتصوّر وتتمثّل في النشأة الآخرة بصورة النهر والحوض، فهي هما في الحقيقة، فلا منافاة بين ما تقدّم وبين التفسير بهما، فتأمّل.
قال الله سبحانه بعد أن امتنّ على رسوله النبيل بهذا العطاء الجزيل :( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) فالعقل السليم شاهد بوجوب شكر المنعم، فكلّما عظمت النعمة حكم العقل بعظم الشكر في مقابلته، ولمّا كانت العطيّة في المقام من أعظم العطايا أمر المنعم الحقيقيّ عبده بأداء شكره في ضمن ما هو من أعظم العبادات وهو الصلاة والنحر. ولعلّ المراد بهما على ما صرّح به في العرائس : الوصل بنور الربوبيّة ؛ بخالص العبوديّة، ونحر النفوس قربانا لكشف المشاهد.
قال : أي اتّصل بنور الربوبيّة بخالص العبوديّة وانحر نفسك قربانا لكشف مشاهدتي(٢) . انتهى.
__________________
(١) مجمع البيان ١٠ : ٥٤٩.
(٢) عرائس البيان : ٣٨٦.
فيحتمل أن يكون المراد بالصلاة المأمور بها في المقام هو الفناء في ساحة الحقّ بكمال الخضوع والخشوع، والإقبال بالكلّيّة على الحقّ، وبالنحر : الفناء الكلّيّ المعبّر عنه بالفناء عن الفناء، والاستغراق الكلّيّ في بحر الشهود ؛ بحيث لا يرى فيه سوى وجه الحقّ ؛ إذ كلّ شيء هالك إلّا وجهه.
قال في الكشّاف : والمعنى أعطيت ما لا غاية لكثرته من خير الدارين الّذي لم يعطه أحد غيرك، ومعطي ذلك كلّه أنا إله العالمين فاجتمعت لك الغبطتان السنيّتان ؛ إصابة أشرف عطاء وأوفره من أكرم معط، وأعظم منعم، فاعبد ربّك الّذي أعزّك بإعطائه، وشرّفك وصانك من منن الخلق مراغما لقومك الّذين يعبدون غير الله، وانحر لوجهه(١) وباسمه، مخالفا لهم في النحر للأوثان(٢) . انتهى.
واختلف المفسّرون في الصلاة والنحر المأمور بهما، فقيل : المراد بالصلاة : صلاة عيد الأضحى، وبالنحر نحر الهدي والأضحية.
وقيل : كان النبيّ صلّى الله عليه وآله ينحر قبل الصلاة، فأمر بأن يصلّي ثمّ ينحر.
وقيل : المراد بالصلاة : صلاة الصبح ؛ أمر بأن يصلّيهما بجمع، أي : بالمزدلفة، وينحر البدن بمنى.
وقيل : المراد بالصلاة : جنس الصلاة المفروضة، وبالنحر : استقبال القبلة بالنحر.
__________________
(١) في المصدر زيادة : إذا نحرت.
(٢) الكشّاف ٤ : ٢٩٠ ـ ٢٩١.
وقيل : المراد بذلك : التكفير ؛ بوضع اليد اليمنى على اليسرى كما هو المعمول به عند العامّة، وقد غلط من نسبه إلى أمير المؤمنين عليه السلام. ويستفاد من جملة من رواياتنا أنّ المراد بالنحر : رفع اليدين حذاء الوجه للقنوت.
ومن هنا ربّما قيل بوجوبه لظاهر الأمر، ومن بعضها أنّ المراد به : أن يستقبل باليدين حذو الوجه عند افتتاح الصلاة بالتكبير.
ومن بعضها : أنّ رفع اليدين عند الافتتاح والركوع بعد رفع الرأس عنه والسجود كذلك(١) . وإذا عكست «صلّ ربّك» صار «كبّر لص» والصاد إشارة إلى الصلاة وتخصيص التكبير بالذكر مع اشتمال الصلاة على أفعال وأقوال كثيرة. فإنّ حقيقته استحقار جميع ما سوى الحقّ عند ذكره، والتوجيه إليه بالكلّيّة، بل المكبّر الحقيقيّ لا يرى شيئيّة حقيقيّة لغير الله، فمراده أنّه أكبر من كلّ موهوم الشيئيّة.
ولنعم ما قيل :
لو أقسم المرء بالرحمن خالقه |
بأنّ كلّ الورى لا شيء ما حنثا |
|
إن كان شيء فغير الله خالقه |
الله أكبر من أن يخلق العبثا |
قال سبحانه :( إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ) .
الشانئ : المبغض، والأبتر : المقطوع الذنب، والمعدم، والخاسر، وكلّ أمر منقطع من الخير، ومن لا عقب ولا نسل له.
ولمّا كان العلّة الغائيّة للإيجاد والوجود الوصول إلى الفيض والجود،
__________________
(١) انظر : مجمع البيان ١٠ : ٥٤٩ ـ ٥٥٠.
وكان ذلك متوقّفا على متابعة محمّد صلّى الله عليه وآله ومحبّته، انحصر كمال الوجود فيه وفي كلّ من أحبّه واتّبعه، فمبغضه لا محالة ناقص الوجود، عادم الفيض والجود، منقطع عن الوصول إلى مقام الكشف والشهود. فيكون محروما عن جميع خيرات الدارين، قد خسر الدنيا والآخرة ؛ ذلك هو الخسران المبين.
ولمّا كان الغرض المهمّ من بقاء النسل والعقب : بقاء الذكر ودوامه بعد الموت، فمبغضه لكونه منسيّ الذكر، أو مذكورا باللعن هو الأبتر، لا هو صلّى الله عليه وآله لأنّه مرفوع الذكر، مذكور الاسم إلى يوم القيامة. هذا مع أنّ ذرّيّته من ولد بنته فاطمة صلوات الله عليها قد ملأوا ما بين المشرق والمغرب.
وفي التفسير الصادقي : إنّه دخل رسول الله صلّى الله عليه وآله المسجد وفيه عمرو بن العاص والحكم بن العاص، فقال عمرو : أتانا الأبتر! وكان الرجل في الجاهليّة إذا لم يكن له ولد يسمّى(١) أبتر، ثمّ قال عمرو : لأشنأته(٢) ، أي أبغضته. فأنزل الله على رسوله :( إِنَّا أَعْطَيْناكَ ) إلى آخره ؛ أي مبغضك عمرو بن العاص هو الأبتر ؛ يعني لا دين [ولا نسب](٣) له(٤) .
تمّت النسخة الشريفة في السابع والعشرين
من شهر ذي الحجّة الحرام سنة ١٣٢٦ ه.
__________________
(١) في المصدر : سمّي.
(٢) كذا في الأصل، وفي المصدر : إنّي لأشنأ محمّدا.
(٣) أضفناه من المصدر.
(٤) تفسير عليّ بن إبراهيم ٢ : ٤٤٥، تفسير نور الثقلين ٥ : ٦٨٥.
تفسير
سورة التوحيد
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[المقدّمة]
الحمد لله الواحد الأحد القيّوم الدائم الصمد، الّذي لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة على محمّد عبده ورسوله المسدّد، المحمود الأحمد، وآله المعصومين، صلاة متّصلة بدوام الأبد.
أمّا بعد، فيقول العبد المفتاق إلى ربّه الصمد «حبيب الله بن علي مدد» : إنّ هذه عجالة وجيزة في تفسير سورة( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) المسمّاة بـ «أسماء كبيرة» سنذكر وجه تسميتها بها في الخاتمة.
فاعلموا إخواني أنّ هذه السورة على مذهبنا معاشر الإماميّة خمس آيات، وإن عدّها من خالفنا أربعا ؛ على ما يقتضيه مذهبه.
الآية الأولى : البسملة
وتفسيرها محتاج إلى تدوين كتاب على حدة، ولكنّنا قد أشرنا إلى بعض ما يتعلّق بها في «تفسير الفاتحة»، وفي «التفسير المنسوب إلى الإمام العسكريّ عليه السلام» أي أستعين على هذا الأمر بالله الّذي لا يستحقّ العبادة غيره، المغيث إذا استغيث، والمجيب إذا دعي، «الرحمن» الّذي يرحم ببسط
الرزق علينا، «الرحيم» بنا في أدياننا ودنيانا وآخرتنا، خفّف الله علينا الدين، وجعله سهلا خفيفا، وهو يرحمنا بتمييزنا من أعدائه.
الآية الثانية :( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ )
وهذه الآية مشتملة على أربع كلمات من نوعي الكلمة على القراءة المشهورة من إثبات الأولى،أو ثلاث على الشاذّة من إسقاطها، واستيفاء البحث عنها في مقاصد أربعة :
[المقصد] الأوّل : في الأولى [وهي كلمة «قل»]
وهي مشتقّة من «القول» بالأصغر، وتقليباته ستّة بالأكبر كما في كلّ ثلاثيّ، فإنّها الحاصلة من ضرب الثلاثة في الاثنين، كما أنّها في الرباعيّ أربعة وعشرون، وفي الخماسيّ مائة وعشرون. فإنّ الأولى من الأربعة في الستّة، والثانية من الخمسة في الأولى، والموضوع في تقليبات الأخيرين ولا سيّما الأخير نزر ؛ بخلاف الأوّل لكثرة الموضوع فيه ؛ بل قد لا يوجد في تقليباته مهمل كما في قول المبحوث عنه.
أمّا «القول» فواضح.
و «القلو» بالكسر ؛ كما في القاموس(١) : «الخفيف من كلّ شيء» و «الحمار الفتيّ» وبهاء الدابّة تتقدّم بصاحبها. وفسّره الرازيّ بحمار الوحش.
__________________
(١) القاموس المحيط ٤ : ٣٨٢.
و «الوقل» بالسكون : «شجرة المقل» أو «ثمره» أو «يابسه» ويقال : «وقل في الجبل» : إذا صعده. وربّما يفسّر «الوقل» بالوعل، وهو «تيس الجبل».
و «الولق» : السرعة، ويقال : «ولق» «يلق» : إذا أسرع.
و «الولقى» : الناقة السريعة.
و «اللوق» كاللوقة : الزبدة من اللّبن، ويقال : «لوّق طعامه» : إذا أصلحه بالزبد. ومنه الحديث : «لا آكل الطعام إلّا ما لوّق لي»(١) .
و «اللقو» كاللقوة : العقاب أو الأنثى منه، أو السريعة الخفيفة، وبالكسر : المرأة السريعة اللقاح.
وفي تفسير الرازيّ وكلّيّات أبي البقاء : إنّ تركيب «القول» في جميع تقاليبه يدلّ على الخفّة والسهولة(٢) . وفيه نظر، لانتقاضه بالنسبة إلى بعض المعاني وإن أمكن بالنسبة إلى أكثرها، فتدبّر.
وفي الثاني : إنّ «القول» و «الكلام» و «اللفظ» من حيث اللغة بمعنى ؛ يطلق على كلّ حرف من حروف المعجم، ومن حروف المعاني، وعلى أكثر منه مفيدا كان أو لا، لكنّ «القول» اشتهر في المفيد بخلاف «اللفظ» واشتهر «الكلام» في المركّب من جزئين فصاعدا. انتهى.
ومن خواصّ هذا الباب أنّ المفعول فيه لا تكون إلّا جملة، ومن هنا يكسر همزة «إنّ» في صدرها لئلّا تؤوّل بالمفرد، وهل هي حينئذ مفعول به أو مفعول مطلق نوعي لدلالتها على نوع خاصّ من القول؟ خلاف، والأصحّ
__________________
(١) النهاية، لابن الأثير ٤ : ٢٧٨.
(٢) انظر : التفسير الكبير ٣٢ : ١٧٤.
الأشهر هو الأوّل، لصحّة الإخبار عنها بأنّها مقولة، والمطلق النوعي ليس بهذه المثابة لكونه عين الفعل، والفعل والمفعول به متغايران كما لا يخفى.
المقصد الثاني : في الثانية : [وهي كلمة «هو»]
وهي بحر فيها اسم وضمير، مرجعه الغائب.
وفي كتاب سيبويه : وأمّا المضمر المحدّث عنه، فعلامته «هو» وإن كان مؤنثا فعلامته «هي». انتهى.
هذا مذهب البصريّين، والكوفيّون يزعمون أنّ الاسم هو «الهاء»، و «الواو» إشباع للحركة. وإذا جيء بها للفرق بين النعت والخبر فـ «هو» حرف عند غير الأخفش، وتسمّى فصلا وعمادا، وحينئذ فلا محلّ لها من الإعراب ؛ حتّى عنده، لكونها كـ «صه» و «نزال»، واللّام الداخلة على الوصف على تقدير اسميّتها.
ويستفاد من جملة من الروايات والأدعية استعمال هذه الكلمة اسما ظاهرا من أسماء الله الحسنى، يدخله حرف النداء.
ولكن في الكلّيّات : وليس «هو» من الأسماء الحسنى ؛ بل «هو» ضمير يجوز إرجاعه لكلّ شيء جوهر أو عرض لفظا أو معنى، إلّا أنّ بعض الطائفة يكنّون به عن الحقيقة المشهودة لهم والنور المطلق للمتجلّي لسرائرهم من وراء أستار الجبروت من حيث هي، من غير ملاحظة اتّصافها بصفة من صفاتها، ولذلك يضعونه موضع الموصوف ويجرون عليه الأسماء حتّى اسم الله. انتهى.
وفيه نظر لما أشرنا إليه.
وقد روي عن عليّ عليه السلام أنّه قال : رأيت الخضر في المنام قبل بدر بليلة، فقلت له : علّمني شيئا انتصر به على الأعداء! فقال : [قل] «يا هو يا من لا هو إلّا هو» فلمّا أصبحت قصصتها على رسول الله صلّى الله عليه وآله فقال [لي] : يا عليّ، علّمت الاسم الأعظم! فكان على لساني يوم بدر(١) .
وروي أنّه قرأ يوم بدر( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) فلمّا فرغ قال : يا هو! يا من لا هو إلّا هو! اغفر لي وانصرني على [القوم] الكافرين(٢) .
وروي أنّه كان يقول ذلك أيضا يوم صفّين وهو يطارد، فقال له عمّار بن ياسر : يا أمير المؤمنين، ما هذه الكنايات؟ فقال عليه السلام : اسم الله الأعظم، وعماد التوحيد [لله] (لا إله إلّا هو) [ثمّ قرأ( شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ ) ] وآخر الحشر، ثمّ نزل فصلّى أربع ركعات قبل الزوال(٣) .
وربّما يدّعى أنّ لفظ «هو» مخفّف عن لفظ «الله» ومجرّد عن زوائده، فإنّه إذا حذف منه الألف يبقى «لله» ؛ أي لله ملك السماوات والأرض وما بينهما، أو يسبّح لله ما في السماوات والأرض، وإذا حذف منه اللّام مع الألف الثانية يصير «له» ؛ أي له ما في الكون، وإذا حذف منه «اللّام» الثانية لم يبق سوى «الهاء» فإذا أشبعته صار «هو» فيكون إشارة إلى بساطة المسمّى وتقدّسه عن الاعتبارات والملاحظات والإضافات، لكونه موضوعا بإزاء الهويّة المطلقة الصرفة ؛ بل قد يقال : إنّه ليس باسم ؛ بل هو المسمّى مع قطع النظر عن ملاحظة الاسميّة ؛ فتدبّر.
__________________
(١) بحار الأنوار ٣ : ٢٢٢.
(٢) بحار الأنوار ٣ : ٢٢٢.
(٣) بحار الأنوار ٣ : ٢٢٢.
ومن هنا قيل : إنّه أخصّ وأعلى من لفظ «الله» لدلالته على الهويّة الصرفة الّتي لا يتصوّر معها شوب إضافة أصلا، بخلاف لفظ «الله» فإنّه يدلّ على الألوهيّة الّتي لا تتصوّر إلّا بعد ملاحظة المألوه. ولذا صار «لا إله إلّا هو»، عماد التوحيد ؛ الّذي هو عبارة عن إسقاط الإضافات، فـ «هو» مع كونه أعمّ الأسماء حيث يطلق على جميعها، أخصّها حتّى من «الله»، ولذا قدّمه عليه في هذه الآية المباركة، كما قدّم «الله» على «الأحد» لكونه أخصّ منه، فافهم واغتنم وكن من الشاكرين.
ومن خواصّ هذه الكلمة أنّه لو بسط حرفاها ببسط الترفّع طوبق عددها مع عدد «عليّ» ولو بسط حروف «عليّ» ببسط التنزيل طوبق مع عدد هذه الكلمة فـ( هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ) و( هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ) و( إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ) فكما أنّ هذه الكلمة دليل تدوينيّ على غيب الهويّة، كذلك «عليّ» دليل تكوينيّ عليه، ومرآة للوجود المطلق ؛ خلقه الله من نوره، واصطفاه بعد محمّد صلّى الله عليه وآله من خلقه ليكون دليلا على هويّته، فـ «سبحان الّذي دلّ على ذاته، بذاته وتنزّه عن مجانسة مخلوقاته»(١) .
ومن خواصّها أنّ النطق بها لا يحتاج إلى اللسان عند انبساط النفس وانقباضه، وفي ذلك إشارة إلى أنّ هويّته بذاته ولذاته، وهويّة سائر الهويّات إنّما هي بهويّته، مفتقرة إليها في حدّ أنفسها.
وهذا معنى ما ذكره الشيخ الرئيس من أنّ «ألهو هو» المطلق هو الّذي لا يكون هويّته موقوفة على غيره، وكلّما كان هويّته لذاته سواء اعتبر غيره أو
__________________
(١) جاء هذا المقطع في دعاء الصباح : يا من دلّ على ذاته بذاته، وتنزّه عن مجانسة مخلوقاته.
لم يعتبر فـ «هو هو» لكن كلّ ممكن فوجوده من غيره، وكلّما كان وجوده من غيره فخصوصيّة وجوده منه، وذلك هو الهويّة ؛ فإذن كلّ ممكن فهويّته من غيره، والّذي يكون هويّته لذاته فهو واجب الوجود. انتهى.
وبالجملة : لا نعرف من ذاته تعالى إلّا أنّه هو ضرورة أنّ كلّ شيء فـ «هو هو»، فإذا قلت : إنّ الله هو هو، فلا مجال لأحد في تكذيب هذا القول ؛ حيث لا يتوقّف تصديقه على معرفته بالكنه والحقيقة الذاتيّة معرفة تفصيليّة لم يصل إليها أحد سواه، كيف وقد عجزت عن كنه ذاته عميقات مذاهب التفكير، وانحسر عن إدراكه بصر البصير.
فيك يا أعجوبة الكون غدا الفكر كليلا |
أنت حيّرت ذوي اللّب وبلبلت العقولا |
كلّما أقبل فكري فيك شبرا فرّ ميلا
وقد بان من هذا البيان أنّ «هو» هو الاسم الأعظم الأعلى المطابق للواقع ونفس الأمر الّذي كلّ الأسماء عنه ومنه وإليه وبه، ومنه وجد كلّما وجد، وبه ظهرت هويّة كلّ شيء، وقد( شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ ) وكيفما كان فلفظ «هو» في هذه السورة محتمل لوجهين :
الأوّل : أن يكون اسما مضمرا، وهذا على وجهين :
أحدهما : أن يكون راجعا إلى ما سألوا عن صفته ونسبته، فقد ذكر عليّ بن إبراهيم القمّيّ في تفسيره أنّ سبب نزول هذه السورة أنّ اليهود جاءت إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله فقالت له : ما نسب ربّك؟ فأنزل الله هذه السورة(١) .
__________________
(١) تفسير القمّيّ ٢ : ٤٤٨.
وفي الكافي والتوحيد عن الصادق عليه السلام قال : إنّ اليهود سألوا رسول الله صلّى الله عليه وآله فقالوا : انسب لنا ربّك، فلبث ثلاثا لا يجيبهم، ثمّ نزلت «قل هو الله»(١) .
وفي التوحيد عن الباقر عليه السلام [في قول الله عزّ وجلّ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ] قال : «قل» ؛ أي أظهر ما أوحينا إليك ونبّأناك [به] بتأليف الحروف الّتي قرأناها لك لتهتدي بها من ألقى السمع وهو شهيد، و «هو» اسم مشار ومكنّى إلى غائب فـ «الهاء» تنبيه على معنى ثابت، و «الواو» إشارة إلى الغائب عن الحواسّ، كما أنّ قولك «هذا» إشارة إلى الشاهد عند الحواسّ، وذلك أنّ الكفار نبّهوا عن آلهتهم بحرف إشارة إلى الشاهد المدرك فقالوا : هذه آلهتنا المحسوسة المدركة بالأبصار، فأشر أنت يا محمّد إلى إلهك [الّذي] تدعو إليه حتّى نراه وندركه ولا نأله فيه، فأنزل الله تبارك وتعالى( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ، فالهاء تثبيت للثابت، والواو إشارة إلى الغائب عن درك الأبصار ولمس الحواسّ، وأنّه تعالى عن ذلك ؛ بل هو مدرك الأبصار ومبدع الحواس(٢) .
ولعلّ المراد بتثبيت الثابت الحكم ثبوت ما هو ثابت في الواقع وموجود في الخارج ؛ إذ لا معنى للإرجاع إلى المعدوم في نفس الأمر. وأمّا قولهم : إنّ شريك الباري هو ممتنع حيث يرجع الضمير إلى ما ليس بثابت في الواقع، فمعناه أنّ هذا المفهوم الثابت لهذا اللفظ بحسب الدلالة عند الذهن ممتنع المصداق في الخارج، فالمرجع هو الثابت في الذهن خاصّة وإن لم يكن
__________________
(١) انظر : الكافي ١ : ٩١، التوحيد : ٩٣.
(٢) التوحيد : ٨٨.
ثابتا في حاقّ الواقع الخارجيّ، فافهم.
ولكونه تعالى ثابتا بحقيقة الثبوت كان من أسمائه الحقّ.
وعن «المعلّم الثاني» : يقال «حقّ» للقول المطابق للمخبر عنه إذا طابق القول، ويقال «حقّ» للموجود الحاصل بالفعل، ويقال «حقّ» للموجود الّذي لا سبيل للبطلان إليه، والأوّل تعالى حقّ من جهة الخبر عنه، وحقّ من جهة الوجود، وحقّ من جهة أنّه لا سبيل للبطلان إليه، لكنّا إذا قلنا أنّه الحقّ فلأنّه الواجب الّذي لا يخالطه بطلان، وبه يجب وجود كلّ باطل.
ألا كلّ شيء ما خلا الله باطل |
[وكلُّ نعيم لا محالةَ زائلٌ] |
ولعلّ المراد بقوله «والواو إشارة إلى الغائب» أنّ الواو لمـــّـا كانت في الأصل علامة للجمع الغائب فهو في هذه الكلمة إشارة إلى غيبته تعالى عن الأبصار، ومن هنا قد يقال : إنّ الواو إشارة إلى جامعيّة هذا المسمّى لجميع الأسماء والصفات الكماليّة، ولعلّه مراد من قال : إنّ بسيط الحقيقة كلّ الأشياء. فتأمّل.
وثانيهما : أن يكون ضمير الشأن والقصّة مفسّرا بما بعده من الجملة، وهذا الضمير قد يكون مرفوعا منفصلا ؛ كما في هذه الآية، وكما في قوله :
هي الدنيا تقول بملء فيها |
[حذار حذار من بطشي وفتكي] |
وقد يكون منصوبا متّصلا بارزا ؛ كما في قوله تعالى :( فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ ) (١) .
وقد يكون مرفوعا مستترا ؛ كما في قوله :
__________________
(١) الحجّ : ٤٦.
إذا متّ كان الناس صنفان إلى آخره.
وحذفه منصوبا نادر إلّا في باب «أنّ» المفتوحة المخفّفة، فإنّه لازم على ما صرّحوا به. وكيف كان فلا بدّ أن يكون المفسّر لهذا الضمير جملة.
قال الرضيّ : والمراد بهذا الضمير، الشأن والقصّة، فيلزمه الإفراد والبية، والمعود إليه إمّا يكون مذكّرا وهو الأغلب، أو مؤنّثا ؛ كما يجيء، وهذا الضمير كأنّه راجع في الحقيقة إلى المسئول عنه بسؤال مقدّر، يقول مثلا هو الأمير مقبل كأنّه سمع ضوضاء وجلبة فاستبهم الأمر فسأل ما الشأن والقصّة؟
فقلت : هو الأمير مقبل ؛ أي الشأن هذا، فلمّا كان المعود إليه الّذي تضمّنه السؤال غير ظاهر قيل اكتفى في التفسير بخبر هذا الضمير الّذي يتعقّبه بلا فصل، لأنّه معيّن للمسؤول عنه ومبيّن له، فبان لك بهذا أنّ الجملة بعد الضمير لم يأت بها لمجرّد التفسير ؛ بل هي كسائر أخبار المبتدءات ؛ لكن سمّيت تفسيرا لما بيّنته، والقصد بهذا الإبهام ثمّ التفسير : تعظيم الأمر، وتفخيم الشأن، فعلى هذا لا بدّ أن يكون مضمون الجملة المفسّرة شيئا عظيما يعتنى به، فلا يقال : هو الذباب يطير. انتهى.
الثاني : أن يكون اسما ظاهرا من أسمائه تعالى على التفصيل الّذي عرفته، فيكون الهاهوت مشتقّا منه، كما أنّه اللاهوت مشتقّ من لفظ «الله» وعلى جميع هذه الوجوه فـ «هو» مبتدأ خبره جملة «الله أحد» واتّحادهما معنى مغن عن الرابطة اللازمة في الجمل الخبريّة ؛ ومن المحتمل كون «أحد» خبرا بعد الخبر، وكونه بدلا عنه، فلا حاجة إلى الرابطة، لعدم الاشتقاق.
المقصد الثالث : في الثالثة
والكلام فيها في مواضع ؛ أحدها في خصائصها، وهي كثيرة :
منها : أنّه لو قسّمت عدد هذه الكلمة ؛ أي عدد حروفها المكتوبة على القسمين كان كلّ قسم ثلاثة وثلاثين، فإذا ضربت هذا العدد في حروفها الأصليّة وهي ثلاثة طوبقت مع عدد «الأسماء الحسنى» وهو تسعة وتسعون، فيكون إشارة إلى جامعيّة هذا الاسم لمعاني جميع الأسماء، فمن دعا به فكأنّما دعا بجميعها، وهذه الخاصّة نقلها الكفعميّ رحمه الله عن محمّد بن طلحة(١) .
ومنها : ما ذكره أيضا من أنّه لو أخذت من طرفي الجلالة ستّة ثلاثة من الأوّل وثلاثة من الآخر وقسّمت على حروفها الأربعة كان لكلّ واحد ونصف، فإذا ضرب الواحد والنصف في عدد الجلالة وهو ستّة وستّون كان حاصل الضرب تسعة وتسعين عدد الأسماء الحسنى الّتي من أحصاها دخل الجنّة(٢) .
ومنها : أنّه لو عكست هذه الكلمة صارت «هللا» على صيغة الماضي ؛ أي هلّل محمّد وعليّ قبل المهلّلات ؛ كما ورد في بعض الروايات، أو على صيغة الأمر فالخطاب لهما عليهما السلام وآلهما.
ومنها : أنّ هذه الكلمة باقية بعد وضع المكرّرات من كلمة التهليل، كما أنّ هذه الكلمة مستخرجة بتمامها منها بعكس «الألف» و «اللّام» الأولى بصيرورتهما «لا» فإذا اجتمع ذلك مع الباقي صار «لا إله» ومع كسر الألف
__________________
(١ و ٢) مصباح الكفعميّ : ٣١٦.
يصير «إلّا» فإذا جمع مع لفظ «الله» صار المجموع «لا إله إلّا الله».
ومنها : أنّه لو أخذ عدد أصل هذه الكلمة وهو «إله» (٣٦) مع عدد مكرّرها (٦٦) يصير مائة واثنين، وهو موافق مع عدد «أعلى» في قوله( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) (١) فيكون إشارة إلى كون هذه الكلمة : الاسم الأعظم الأعلى ؛ وهذه الخصائص قد ذكرناها مع زيادة في تفسيرنا على سورة الفاتحة.
الثاني : هل هذه الكلمة عربيّة أو عبرانيّة أو سريانيّة الحقّ هو الأوّل ؛ لقوله تعالى :( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ ) (٢) وقوله( هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ) (٣) وقد تكرّر ذكر هذه الكلمة في القرآن أكثر من ذكر سائر الأسماء، وعددها فيه ألفان وثمانمائة وسبعة.
الثالث : هل هي من أسماء الأعلام الشخصيّة أو من المشتقّات المبهمة الكلّيّة؟ الحقّ هو الأوّل، لما ذكره الرازيّ في تفسيره الكبير(٤) ، من أنّه لو كان مشتقّا لكان معناه معنى كلّيّا لا يمنع نفس مفهومه من وقوع الشركة فيه، قال : لأنّ لفظ المشتق لا يفيد إلّا أنّه شيء ما مبهم حصل له ذلك المشتقّ منه، وهذا المفهوم لا يمنع من وقوع الشركة فيه بين كثيرين. فثبت أنّ هذا اللفظ لو كان مشتقّا لم يمنع من وقوع الشركة فيه بين كثيرين، فلو كان كذلك لما كان قوله «لا إله إلّا الله» توحيدا حقّا مانعا من وقوع الشركة فيه بين كثيرين، لأنّ بتقدير أن يكون «الله» لفظا مشتقّا كان قولنا «الله» غير مانع من أن يدخل تحت أشخاص
__________________
(١) الأعلى : ١.
(٢) الزخرف : ٨٧.
(٣) مريم : ٦٥.
(٤) انظر : التفسير الكبير ٣٢ : ١٧٩.
كثيرة ؛ فحينئذ لا يكون قولنا «إلّا الله» موجبا للتوحيد المحض، وحيث أجمع العلماء على أنّ قولنا «لا إله إلّا الله» يوجب التوحيد المحض علمنا أنّ قولنا «الله» اسم علم لتلك الذات المعيّنة، وأنّها ليست من الألفاظ المشتقّة. انتهى.
واحتجّ له أيضا بأنّ من أراد أن يذكر ذاتا معيّنة ثمّ يذكره بالصفات، فإنّه يذكر اسمه أوّلا ثمّ يذكر عقيب الاسم الصفات، ومن أراد أن يذكر الله بالصفات المقدّسة فإنّه يذكر أوّلا لفظ «الله» ثمّ يذكر بعده الصفات، فيقول : «الله العالم القادر» فهذا يدلّ على أن لفظ «الله» علم، لا أنّ مفهومه الكلّيّ، لكونه مشتقّا، ولا يذهب عليك أنّ هذين الوجهين لا ينفيان كون هذا اللفظ مشتقّا في الأصل وصيرورته عليما، فيكون «الألف» و «اللّام» للمح، فتأمّل.
واحتج للثاني بوقوعه صفة في قوله( وَهُوَ اللهُ فِي السَّماواتِ ) (١) وقوله( هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ ) (٢) وفيه ما لا يخفى، كالاحتجاج له بأنّ اسم العلم قائم مقام الإشارة، فكما أنّ الإشارة إلى ذاته تعالى ممتنعة، فكذلك وضع العلم المعيّن للحقيقة والذات، فإنّ أسماء الله توقيفيّة، فإذا كان واضعها هو الله فلا مانع من وضعه هذا الاسم لذاته. هذا، مع أنّه لا يشترط في الوضع المعرفة بالكنه. وكيف كان فالفرق بين هذا اللفظ ولفظ «الإله» أنّ هذا اللفظ لا يطلق إلّا على المعبود بالحقّ، وهو الجامع لجميع الصفات الكماليّة من الجمال والجلال، بخلاف الثاني لإطلاقه على مطلق ما عبد ؛ سواء عبد بحقّ أو بباطل.
__________________
(١) الأنعام : ٣.
(٢) الحشر : ٢٢ و ٢٣.
والمراد بالمعبود بالحقّ هو المستحقّ للعبوديّة لا المعبود بالفعل، فلا يلزم أن يكون إلها في الأزل كما توهّمه الرازيّ، مع أنّه قال بعد ذلك : واعلم أنّه تعالى هو المستحقّ للعبادة، لأنّه هو المنعم بجميع النعم أصولها وفروعها، وذلك لأنّ الموجود إمّا واجب وإمّا ممكن، والواجب واحد وهو الله سبحانه تعالى، وما سواه ممكن، والممكن لا يوجد إلّا بالمرجّح، فكلّ الممكنات إنّما وجدت بإيجاده وتكوينه ؛ إمّا ابتداء، أو بواسطة، فجميع ما حصل للعبد من أقسام النعم لم يحصل إلّا من الله، فثبت أنّ غاية الإنعام صادرة من الله، والعبادة غاية التعظيم.
وإذا ثبت هذا فنقول : إنّ غاية التعظيم لا تليق إلّا لمن صدرت عنه غاية الإنعام، فثبت أنّ المستحقّ للعبوديّة ليس إلّا الله. انتهى، فتدبّر.
الرابع : على تقدير اشتقاق هذا اللفظ يحتمل فيه وجوه كثيرة :
منها : أنّه مشتقّ من «ألهت إلى فلان» ؛ أي سكنت إليه، فإنّ العقول لا تسكن إلّا إلى ذكره، والأرواح لا تفرح إلّا بمعرفته، والقلوب لا تطمئنّ إلّا بمحبّته.
ومنها : أنّه مشتقّ من «الألوهة» و «الإلهة» ؛ أي العبادة.
قال في القاموس : «أله، ألاهة وألوهة وألوهية» : عبد عبادة، ومنه لفظ الجلالة(١) . وقرأ ابن مسعود وابن عبّاس( وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ ) (٢) ؛ أي عبادتك.
ومنها : أنّه مشتقّ من «أله بالمكان» إذا قام به ؛ فمعنى «الله» : القائم بالذات،
__________________
(١) القاموس المحيط ٤ : ٢٨٢.
(٢) الأعراف : ١٢٧.
الّذي في وجود كلّ موجود وقائم به.
ومنها : أنّه من «أله الفصيل» إذا ولع بأمّه، فإنّ العباد مولعون بالتضرّع إليه في جميع الأحوال، ألا ترى أنّ الإنسان إذا ابتلي ببلاء عظيم نسي جميع الأشياء إلّا الله فيقول بقلبه ولسانه «يا الله!» و «يا ربّ!».
ومنها : أنّه من «ألهت إليه» إذا قدرت عليه، فإنّه على كلّ شيء قدير.
ومنها : أنّه من «أله إليه» إذا فزع إليه من أمر نزل به فـ «ألهه» ؛ أي أجاره، فإنّه تعالى هو الّذي يفزع إليه الخلائق عند الشدائد، فيجيرهم منها.
ومنها : أنّه من «أله الرجل» إذا تحيّر، فإنّه إذا تفكّر فيه العبد، تحيّر ولم يصل إلى كنهه وحقيقته، فكلّما يتخيّله ويتصوّره فهو غيره.
قال الباقر عليه السلام : «الله» معناه المعبود الّذي أله الخلق عن درك ماهيّته والإحاطة بكيفيّته، ويقول العرب : «أله الرجل» إذا تحيّر في الشيء فلم يحط به علما(١) . انتهى.
ومنها : أنّه من «الوله» وهو ذهاب العقل والحيرة، فإنّ الخلق على ما ذكره الرازيّ قسمان : واصلون إلى ساحل بحر المعرفة، ومحرومون قد بقوا في ظلمات بحر الحيرة وميتة الجهالة، فكأنّهم فقدوا عقولهم وأرواحهم، وأمّا الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور، وفسحة الكبرياء والجلال، فتاهوا في ميادين الصمديّة، وبادوا في عرصة الفردانيّة، فثبت أنّ الخلق كلّهم والهون في معرفته.
قال : وبعبارة أخرى ؛ إنّ الأرواح البشريّة تسابقت في ميادين التوحيد
__________________
(١) بحار الأنوار ٣ : ٢٢١.
والتمجيد، فبعضها تخلّفت، وبعضها سبقت، فالّتي تخلّفت بقيت في ظلمات الغبار، والّتي سبقت وصلت إلى عالم الأنوار، فالأوّلون بادوا في أودية الظلمات، والآخرون طاشوا في أنوار عالم الكرامات.
ومنها : أنّه من «لاه» الّتي أصلها «ليه» بمعنى اختفى وغاب، لكونه تعالى غائبا عن مشاهدة الأبصار، وعن درك الأفهام.
ومنها : أنّه من «لاه» الّتي أصلها «لوه» بمعنى ارتفع، لأنّه تعالى علا فاستعلى وارتفع عن مشابهة الممكنات، ومناسبة المخلوقات.
قال الرازيّ : لأنّ الواجب لذاته ليس إلّا هو، والكامل لذاته ليس إلّا هو، والأحد الحقّ في هويّته ليس إلّا هو، والموجد لكلّ ما سواه ليس إلّا هو ؛ وفي الدعاء «ارتفعت عن صفة المخلوقين صفات ذاتك وقدرتك، وعلا عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك».
وكيفما كان فقد صرّح أبو البقاء في كلّيّاته : بأنّ هذا اللفظ تعيّن في كلمة التوحيد علامة للإيمان، ولم يعلم له سميّ في اللسان، لكنّ الله سبحانه قبض الألسن عن أن يدعى به أحد سواه، وكما تاهوا في ذاته وصفاته لا حتجابها بأنوار العظمة وأستار الجبروت، كذلك تحيّروا في اللفظ الدالّ عليه أنّه اسم، أو صفة مشتقّ أو غير مشتقّ؟ علم أو غير علم؟ إلى غير ذلك، كأنّه انعكس إليه من مسمّاه أشعّة من تلك الأنوار، فقصرت أعين المستبصرين عن إدراكه.
إشارة : ربّما يجعل هذا اللفظ في هذه الآية بدلا من «هو» فخبره «أحد» ففيه رمز إلى أنّ صفاته عين الذات ؛ إذ لا يتصوّر لهويّته الأحديّة سوى الذات البحث، ومن هنا قال سيّد الموحّدين أمير المؤمنين عليه السلام «كمال
التوحيد نفي الصفات عنه»(١) .
المقصد الرابع : في الرابعة :
فنقول : الفرق بين واحديّته سبحانه المنصوص عليها في مواضع من الكتاب وفي كثير من الأدعية المأثورة عن الأئمّة المعصومين الأطياب، وبين أحديّته الّتي أخبر بها في هذه الآية المباركة وأمر نبيّه صلّى الله عليه وآله بإظهارها لعباده، أنّ الواحديّة عبارة عن كونه تعالى بحيث لا شريك له في وجوب الوجود بالذات، وفي الوجود الحقيقيّ ولا في الإلهيّة، ولا في الخالقيّة، ولا في غير ذلك من الصفات الكماليّة الحقيقيّة.
وبعبارة أخرى : لم يتحقّق في الخارج لمفهوم واجب الوجود فرد سوى الحقّ الموجود في نفسه لنفسه بنفسه، وذلك لأنّه تعالى صرف الوجود، وصرف الوجود إمّا مقتض للوحدة، أو للكثرة، أو لا يقتضي شيئا منهما، لا سبيل إلى الثاني لإيجابه عدم تحقّق الواحد أصلا، فلا يتحقّق الكثير، فإنّه مبدئه، ولا إلى الثالث لاستلزامه كونه تعالى في وحدته معلّلا بالغير، فتعيّن الأوّل وهو المطلوب، والبراهين على وحدانيّته بالمعنى المذكور ساطعة ؛ بل
وفي كلّ شيء له آية |
تدلّ على أنّه واحد |
وشبهة ابن كمّونة حيث قال : لم لا يجوز أن يكون هناك هويّتان بسيطتان مجهولتا الكنه مختلفتان بتمام الماهيّة، يكون كلّ منهما واجب الوجود بذاته، ويكون مفهوم واجب الوجود منتزعا منهما مقولا عليهما
__________________
(١) جاءت هذه الرواية في نهج البلاغة في الخطبة الاولى هكذا : «... وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه ...».
قولا عرضيّا، واهية واضحة الدفع، مع أنّها في مقابلة الضرورة، وأوهى منها شبهة الثنويّة وسائر ما ربّما يتوهّم من الشبهات الواهية، وأوهن من الجميع الشبهة في وجود الصانع الحقّ تعالى( أَفِي اللهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ) (١) تعالى الله عما يصفون وسبحانه عما يشركون.
و «الأحديّة» عبارة عن بساطته وتنزّهه عن التركيب من الأجزاء العقليّة والخارجيّة، فإنّ كلّ مركّب مفتقر في تقوّمه إلى الأجزاء، وواجب الوجود لا بدّ أن يكون غنيّا بالذات، فكما أنّ لفظ «الله» جامع لمجامع صفاته الجماليّة المعبّر عنها بالصفات الثبوتيّة تارة، وبصفات الإكرام [اخرى]، كذلك لفظ «الأحد» دالّ على مجامع الصفات الجلاليّة المعبّر عنها بالصفات السلبيّة، وهي راجعة إلى سلب واحد، وهو سلب الاحتياج، والإذعان بهذا السلب كما أنّ الإذعان الإجماليّ باتّصافه تعالى بكلّ كمال ذاتيّ كاف عن الإذعان التفصيليّ.
وإن شئت قلت : إنّ الإذعان بوجوب وجوده مغن عن إثبات كلّ واحد واحد من الصفات الحقيقيّة الثبوتيّة ؛ كالعلم والقدرة ونحوهما، فإنّ واجب الوجود لذاته وبذاته لا يعقل أن يكون ناقصا بالجهل والعجز ونحوهما من النقائص، وهذه الصفات مبادئ للصفات الإضافيّة المعبّر عنها بالقيموميّة كالعالميّة والقادريّة ونحوهما من الإضافات، وهي زائدة على الذات ؛ إذ لو كانت عينه لزم كونه نسبة اعتباريّة ؛ إذ المفروض كونها اعتباريّة انتزاعيّة بخلاف غيرها من الصفات الحقيقيّة، فإنّها متّحدة مع الذات ؛ كما حقّق في محلّ آخر.
__________________
(١) إبراهيم : ١٠.
والمراد بالسلب في الصفات السلبيّة هو الحكم بسلب ما كان منفيّا عن الذات في الواقع ممّا كان ثبوته نقصا ؛ مثلا الجوهر له وجود واستقلال ومهيّة، والمنفيّ منه في الذات هو كونه مهيّة، لأنّه صرف الموجود لا الوجود، وبالاستقلال بالذات، وعلى هذا القياس سائر ما يسلب عنه تعالى.
والحاصل : إنّ هنا أمرين كمال ونقص، فالثابت هو الأوّل، وإليه يرجع جميع ما ذكروه من الصفات الثبوتيّة، والمنفيّ هو الثاني، وإليه يرجع جميع الصفات السلبيّة، فمقام الأحديّة راجع إلى التنزّه عن التركيب ولوازمه ممّا يوجب النقص.
وفي تفسير الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليهما السلام : حدّثنا أبو الحسن، قال : حدّثنا الحسن بن عليّ بن حمّاد بن مهران، قال : حدّثنا محمّد بن خالد بن إبراهيم السعديّ، قال : حدّثني أبان بن عبد الله، قال : حدّثني يحيى بن آدم عن القراريّ، عن جوهر، عن الضحّاك، عن ابن عبّاس قال : قالت قريش للنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم بمكّة : صف لنا ربّك لنعرفه ونعبده، فأنزل الله على نبيّه( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ؛ يعني غير منقص، ولا مجزّأ، ولا مكيّف، ولا يقع عليه العدد ولا الزيادة ولا النقصان إلى آخره.
وقد يطلق الأحديّة الذاتيّة على مرحلة من الوجود ليس فيها اسم ولا رسم ولا صفة، وإليها الإشارة في قوله كان الله ولم يكن معه شيء كما يطلق الواحديّة على مرتبة ظهور الأسماء والصفات، وربّما يفرّق بينهما بوجوه اخر.
وعن الأزهريّ : إنّ الأحد صفة من صفات الله استأثر بها، فلا يشركه فيها شيء.
وفي الكلّيّات : ويأتي في كلام العرب بمعنى الأوّل كيوم الأحد، ومنه( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) في أحد القولين، وبمعنى الواحد كقولنا ما في الدار أحد ؛ أي من يصلح للخطاب.
والأحد اسم بني لنفي ما يذكر معه من العدد، والواحد بني لمفتتح العدد، وهمزته إمّا أصليّة وإمّا منقلبة عن الواحد على تقدير أن يكون أصله «وحد» وعلى كلّ من الوجهين يراد بالعدد ما يكون واحد من جميع الوجوه، لأنّ الأحديّة هي البساطة الصرفة عن جميع أنحاء التعدّد عدديّا أو تركيبيّا أو تحليليّا، فاستهلاك الكثرة النسبيّة الوجوديّة في أحديّة الذات، ولهذا رجّح على الواحد في مقام التنزيه، لأنّ الواحد منه عبارة عن انتفاء التعدّد العدديّ، فالكثرة العينيّة وإن كانت منتفية في الواحديّة، إلّا أنّ الكثرة النسبيّة تتعقّل فيها. انتهى.
ثمّ البحث عن مراتب التوحيد وإن كان مناسبا في هذا المقام، إلّا أنّه لا يليق بهذا المختصر، فمن أراد فليراجع شرحي «العديلة».
تذنيب :
قد يقال : إنّ الواحد والأحد بمعنى واحد، ويؤيّده قراءة الأعمش «هو الله الواحد» ويدلّ عليه أيضا : ما رواه في التوحيد عن الباقر عليه السلام قال : الأحد الفرد المتوحّد، والأحد والواحد بمعنى واحد، وهو المتفرد الّذي لا نظير له، والتوحيد الإقرار بالوحدة وهو الانفراد، والواحد المتباين الّذي لا ينبعث من شيء ولا يتّحد بشيء.
ومن ثمّ قالوا : إنّ بناء العدد من الواحد وليس الواحد من العدد، لأنّ
العدد لا يقع على الواحد ؛ بل يقع على الاثنين ؛ فمعنى قوله «الله أحد» ؛ أي المعبود الّذي أله الخلق عن إدراكه والإحاطة بكيفيّته، فرد بإلهيّته، متعال عن صفات خلقه(١) . انتهى.
وروى بسنده إلى المقدام ابن شريح بن هانئ عن أبيه قال : إنّ أعرابيّا قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين فقال : يا أمير المؤمنين، أتقول إنّ الله واحد؟
قال : فحمل الناس عليه وقالوا يا أعرابيّ، أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسّم القلب؟
فقال أمير المؤمنين : دعوه! فإنّ الّذي يريده الأعرابيّ هو الّذي نريده من القوم، ثمّ قال : يا أعرابيّ، إنّ القول في أنّ الله واحد على أربعة أقسام، فوجهان منها لا يجوزان على الله عزّ وجلّ، ووجهان يثبتان فيه ؛ فأمّا اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل «واحد» يقصد به باب الأعداد، فهذا ما لا يجوز، لأنّ ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداء، أما ترى أنّه كفّر من قال : ثالث ثلاثة، وقول القائل : هو واحد من الناس، يريد به النوع من الجنس، فهذا ما لا يجوز عليه لأنّه تشبيه، وجلّ ربّنا عن ذلك وتعالى.
وأمّا الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل «هو واحد» ليس له في الأشياء شبه، كذلك ربّنا، وقول القائل : إنّه عزّ وجلّ أحديّ المعنى ؛ يعني به أنّه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم، كذلك ربّنا عزّ وجلّ(٢) . انتهى.
قال الصدوق بعد ذكر هذا الحديث : سمعت من أثق بدينه ومعرفته
__________________
(١) انظر : بحار الأنوار ٣ : ٢٢١.
(٢) بحار الأنوار ٣ : ٢٠٦، التوحيد : ٨٣.
باللغة والكلام يقول : إنّ قول القائل واحد واثنان وثلاثة إلى آخره، إنّما وضع في أصل اللغة للإبانة عن كمّيّة ما يقال عليه، لا لأنّ له مسمّى يتسمّى به بعينه، أو لأنّ له معنى سوى ما يتعلّمه الإنسان لمعرفة الحساب ويدور عليه عقد الأصابع عند ضبط الآحاد والعشرات والمئين والألوف، ولذا متى أراد مريد أن يخبر غيره عن كمّيّة شيء بعينه سمّاه باسمه الأخصّ، ثمّ قرن لفظ الواحد به وعلّقه عليه يدلّ به على كمّيّته لا على ما عدا ذلك من أوصافه، ومن أجله يقول القائل : «درهم واحد» وإنّما يعني به أنّه درهم فقط، وقد يكون الدرهم درهما بالوزن ودرهما بالضرب، فإذا أراد المخبر أن يخبر عن وزنه قال : «درهم واحد بالوزن» وإذا أراد أن يخبر عن عدده وضربه قال : «درهم واحد بالعدد» و «درهم واحد بالضرب» وعلى هذا الأصل يقول القائل : «هو رجل واحد» وقد يكون الرجل واحدا بمعنى أنّه إنسان، وليس بإنسانين، ورجل ليس برجلين، وشخص، ليس بشخصين، ويكون واحدا في الفضل، وواحدا في العلم، وواحدا في السخاء، وواحدا في الشجاعة، فإذا أراد القائل أن يخبر عن كمّيّته قال : «هو رجل واحد» فدلّ ذلك من قوله على أنّه رجل وليس هو برجلين، وإذا أراد القائل أن يخبر عن فضله قال : «هذا واحد عصره» فدلّ ذلك على أنّه لا ثاني له في الفضل، وإذا أراد أن يدلّ على علمه قال : «إنّه واحد في علمه» فلو دلّ قوله «واحد» بمجرّده على الفضل والعلم كما دلّ بمجرّده على الكمّيّة لكان كلّ من أطلق عليه لفظة واحدة أراد فاضلا لا ثاني له في فضله، وعالما لا ثاني له في علمه، وجوادا لا ثاني له في جوده.
فلمّا لم يكن كذلك صحّ أنّه بمجرّده لا يدلّ إلّا على كمّيّة الشيء دون
غيره ولم يكن لما أضيف إليه من قول القائل : «واحد عصره ودهره» معنى، ولا كان لتقييده بالعلم والشجاعة معنى، لأنّه كان يدلّ بغير تلك الزيادة وبغير ذلك التقييد على غاية الفضل وغاية العلم والشجاعة، فلمّا احتيج معه إلى زيادة لفظ واحتيج إلى تقييده بشيء صحّ ما قلناه.
فقد تقرّر أنّ لفظ القائل «واحد» إذا قيل على الشيء دل بمجرّده على كمّيّته في اسمه الأخصّ، ويدلّ بما يقترن به على فضل المقول عليه، وعلى كماله، وعلى توحّده بفضله وعلمه وجوده، وتبيّن «أنّ الدرهم الواحد» قد يكون درهما واحدا بالوزن، ودرهما واحدا بالعدد، ودرهما واحدا بالضرب، وقد يكون بالوزن درهمين وبالضرب درهما واحدا، وقد يكون بالدوانيق ستّة دوانيق، وبالفلوس ستّين فلسا ويكون بالأجزاء كثيرا، وكذلك يكون العبد عبدا واحدا ولا يكون عبدين بوجه، ويكون شخصا واحدا ولا يكون شخصين بوجه، ويكون أجزاء كثيرة وأبعاضا كثيرة، وكلّ بعض من أبعاضه يكون جواهر كثيرة متّحد بعضها ببعض، وتركّب بعضها مع بعض، ولا يكون العبد واحدا وإن كان كلّ واحد منّا في نفسه إنّما هو عبد واحد، وإنّما لم يكن العبد واحدا لأنّه ما من عبد إلّا وله مثل في الوجود، أو في المقدور.
وإنّما صحّ أن يكون للعبد مثل لأنّه لم يتوحّد بأوصافه الّتي من أجلها صار عبدا مملوكا، ووجب لذلك أن يكون الله عزّ وجلّ متوحّدا بأوصافه العلى، وأسمائه الحسنى، ليكون إلها واحدا، فلا يكون له مثل، ويكون واحدا لا شريك له ولا إله غيره، فالله تبارك وتعالى واحد لا إله إلّا هو، قديم
واحد لا قديم إلّا هو، وموجود واحد ليس بحالّ ولا محلّ ولا موجود كذلك إلّا هو، وشيء واحد لا يجانسه شيء، ولا يشاكله شيء، ولا يشبهه شيء، ولا شيء كذلك إلّا هو، فهو كذلك موجود وغير منقسم في الوجود ولا في الوهم، وشيء لا يشبهه شيء بوجه، وإله لا إله غيره بوجه، وصار قولنا «يا واحد يا أحد» في الشريعة اسما خاصّا له دون غيره لا يسمّى به إلّا هو عزّ وجلّ ؛ كما أنّ قولنا «الله» اسم لا يسمّى به غيره(١) . انتهى كلامه رفع في المقام جنانه.
الآية الثالثة :
( اللهُ الصَّمَدُ ) أقام الظاهر مقام الضمير لئلّا يتوهّم رجوعه إلى «أحد».
وعرّف «الصمد» دون «أحد» قيل : «لعلمهم بصمديّته دون أحديّته».
وأخلى هذه الجملة عن «الواو» الدالّة على المغايرة للإشارة إلى أنّ من كان إلها أحديّ الذات جامعا لكمال الصفات ينبغي أن يصمد إليه في جميع الحاجات، فتكون هذه الجملة بمنزلة النتيجة للجملة السابقة.
وإنّما كرّر الجلالة قيل : «للإشعار بأنّ من لم يتّصف بالصمدانيّة لم يستحقّ الألوهيّة» ويحتمل العكس.
وإفادة الجملة للحصر أيضا جليّة.
[ما هو تفسير الصمد؟]
وكيف كان فقد اختلفت كلمتهم في تفسير «الصمد» على وجوه كثيرة :
__________________
(١) التوحيد : ٨٤ ـ ٨٦.
منها : ما في تفسير الإمام جعفر الصادق عليه السلام من أنّه الّذي قد انتهى إليه السؤدد، والّذي يصمد أهل السماوات والأرض لحوائجهم إليه ؛ أي يقصد.
وفي الكشّاف : «الصمد» فعل بمعنى مفعول، من «صمد إليه» إذا قصده، وهو السيّد المصمود إليه في الحوائج. قال : والمعنى هو الله الّذي تعرفونه وتقرّون بأنّه خالق السماوات والأرض وخالقكم، وهو واحد متوحّد بالإلهيّة لا يشارك فيها، وهو الّذي يصمد إليه كلّ مخلوق لا يستغنون عنه وهو الغنيّ عنهم(١) . انتهى.
ومنها : ما في التوحيد عن الباقر عليه السلام قال : حدّثني أبي زين العابدين، عن أبيه الحسين بن عليّ عليهم السلام قال : «الصمد» الّذي لا جوف له، والصمد الّذي قد انتهى سؤدده، و «الصمد» الّذي لا يأكل ولا يشرب، و «الصمد» الّذي لا ينام، و «الصمد» الدائم الّذي لم يزل ولا يزال(٢) .
ومنها : ما روي عن محمّد بن الحنفيّة أنّه كان يقول : «الصمد» القائم بنفسه، الغنيّ عن غيره(٣) .
وإليه يرجع ما قيل : من أنّه السند المطلق المصمود إليه، الّذي يقصد إليه في جميع الحوائج، ويفتقر إليه كلّ شيء، فهو مؤثّر لا سواه كما قال تعالى( وَاللهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَراءُ ) (٤) .
__________________
(١) الكشّاف ٤ : ٨١٨.
(٢ و ٣) التوحيد : ٩٠، بحار الأنوار ٣ : ٢٢٣.
(٤) محمّد صلّى الله عليه وآله : ٣٨.
ومنها : ما روي عن عليّ بن الحسين عليهما السلام من أنّ «الصمد» الّذي لا شريك له ولا يؤوده حفظ شيء، ولا يعزب عنه شيء(١) .
ومنها : ما روي عن زيد بن عليّ عليه السلام من أنّه الّذي إذا أراد شيئا قال له : كن فيكون، قال : و «الصمد» الّذي أبدع الأشياء فخلقها أضدادا وأشكالا وأزواجا، وتفرّد بالوحدة بلا ضدّ ولا شكل ولا مثل ولا ندّ(٢) .
وتأويلها ما حكي عن بعضهم من أنّه المتعالي عن الكون والفساد، وأنّه الّذي لا يوصف بالتغاير.
ومنها : ما روي من أنّ أهل البصرة كتبوا إلى الحسين بن عليّ عليه السلام يسألونه عن «الصمد» فكتب إليهم( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) أمّا بعد، فلا تخوضوا في القرآن، ولا تجادلوا فيه، ولا تتكلّموا فيه بغير علم، فقد سمعت جدّي رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول : من قال في القرآن بغير علم فليتبوّأ مقعده من النار، وإنّ الله سبحانه قد فسّر «الصمد» فقال :( اللهُ أَحَدٌ * اللهُ الصَّمَدُ ) ثم فسّره فقال :( لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ) (٣) إلى آخره. انتهى.
ومنها : ما روي عن الصادق عليه السلام من أنّه قدم وفد من أهل فلسطين على الباقر عليه السلام فسألوه عن مسائل فأجابهم، ثم سألوه عن «الصمد» فقال : تفسيره فيه، «الصمد» خمسة أحرف : فالألف دليل على إنّيّته
__________________
(١ و ٢) التوحيد : ٩٠، بحار الأنوار ٣ : ٢٢٣.
(٣) التوحيد : ٩٠ ـ ٩١، بحار الأنوار ٣ : ٢٢٣.
وهو قوله عزّ وجلّ( شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ ) (١) وذلك تنبيه وإشارة إلى الغائب عن درك الحواسّ، و «اللّام» دليل على إلهيّته بأنّه هو الله، و «الألف» و «اللّام» مدغمان لا يظهران على اللسان، ولا يقعان في السمع، ويظهران في الكتابة، دليلان على أنّ إلهيّته لطيفة(٢) خافية لا تدرك بالحواسّ، ولا تقع في لسان واصف، ولا اذن سامع، لأنّ تفسير «الإله» هو الّذي أله الخلق عن درك ماهيّته وكيفيّته بحسّ أو بوهم، لا بل هو مبدع الأوهام، وخالق الحواسّ، وإنّما يظهر ذلك عند الكتابة دليل على أنّ الله سبحانه أظهر ربوبيّته في إبداع الخلق وتركيب أرواحهم اللطيفة في أجسادهم الكثيفة، فإذا نظر عبد إلى نفسه لم ير روحه كما أنّ «لام» «الصمد» لا تتبيّن ولا تدخل في حاسّة من حواسّه الخمس، فإذا نظر إلى الكتابة ظهر [له] ما خفي ولطف، فمتى تفكّر العبد في ماهيّة الباري وكيفيّته، أله فيه وتحيّر ولم تحط فكرته بشيء يتصوّر له، لأنّه خالق الصور، فإذا نظر إلى خلقه ثبت له أنّه عزّ وجلّ خالقهم ومركّب أرواحهم في أجسادهم.
وأمّا «الصاد» فدليل على أنّه عزّ وجلّ صادق وقوله صدق، وكلامه صدق، ودعا عباده إلى اتّباع الصدق بالصدق، ووعد بالصدق دار الصدق.
وأمّا «الميم» فدليل على ملكه وأنّه الملك الحقّ لم يزل ولا يزال ولا يزول ملكه.
__________________
(١) آل عمران : ١٨.
(٢) في المصدر : بلطفه.
وأمّا «الدال» فدليل على دوام ملكه وأنّه عزّ وجلّ دائم تعالى(١) عن الكون والزوال ؛ بل هو عزّ وجلّ مكوّن الكائنات، الّذي كان بتكوينه كلّ كائن.
ثمّ قال عليه السلام : لو وجدت لعلمي الّذي آتاني الله عزّ وجلّ حملة لنشرت التوحيد والإسلام والإيمان والدين والشرائع من «الصمد»، وكيف لي بذلك ولم يجد جدّي أمير المؤمنين عليه السلام حملة لعلمه حتّى كان يتنفّس الصعداء ويقول على المنبر «سلوني قبل أن تفقدوني» فإنّ بين الجوانح منّي علما جمّا، هاه هاه، ألا لا أجد من يحمله، ألا وإنّي عليكم من الله الحجّة البالغة فلا تتولّوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفّار من أصحاب القبور.
ثمّ قال الباقر عليه السلام : الحمد لله الّذي منّ علينا ووفّقنا لعبادته، الأحد الصمد الّذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وجنّبنا عبادة الأوثان حمدا سرمدا، وشكرا واصبا، وقوله عزّ وجلّ( لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ) يقول :( لَمْ يَلِدْ ) عزّ وجلّ فيكون له ولد يرثه في ملكه، و( لَمْ يُولَدْ ) فيكون له والد يشركه في ربوبيّته وملكه و( لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ) فيعازه في سلطانه(٢) . انتهى.
وقد روى هذا الحديث الصدوق في التوحيد عن وهب بن وهب القرشيّ، عن الصادق عليه السلام قال : [إلى آخر الرواية].
قوله عليه السلام «دليل على إنّيّته» ؛ أي إشارة إلى مقام حقيقته وأحديّته
__________________
(١) في بعض النسخ : متعال.
(٢) انظر : التوحيد : ٩٢ ـ ٩٣، بحار الأنوار ٣ : ٢٢٤.
الذاتيّة الّتي لا اسم ولا رسم ولا صفة فيها، فإنّه تعالى في هذا المقام هو هو ولا حاكي له بـ «أنا» إلّا هو، فإنّ المحكيّ عنه بـ «أنا» هو ما به هو هو، فهو في هذا المقام عين وجوده الخاصّ الّذي به موجوديّته، وهو غير الوجود الكلّيّ المشترك في مفهومه جميع الموجودات، فإنّه غير الذات وزائد عليه، وإلّا لزم كونه تعالى عين جميع الأشياء، وهو باطل عندنا بالضرورة.
وبالجملة : هو صرف الوجود لا مهيّة له ؛ بل ماهيّته هي إنّيّته الّتي هي عين الوحدة الحقّة والهويّة الشخصيّة على ما صرّح به بعض الأجلّة، وإلّا لزم كونه معلولا، وهو باطل.
قوله عليه السلام «دليل على إلهيّته» ؛ أي إشارة إلى مقام جامعيّته للأسماء والصفات.
الآية الرابعة :
( لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ) فإنّ الوصفين من صفات الأجسام، وهو منزّه عنها.
وفي التفسير الصادقيّ :( لَمْ يَلِدْ ) منه عزير كما قالت اليهود لعنهم الله، ولا «المسيح» كما قالت النصارى سخط الله عليهم، ولا «الشمس» ولا «القمر» ولا «النجوم» كما قالت المجوس لعنهم الله، ولا «الملائكة» كما قال مشركو العرب.
( وَلَمْ يُولَدْ ) ؛ أي لم يكن [في] الأصلاب، ولم تضمّنه الأرحام، لا من شيء كان، ولا من شيء خلق ما كان. انتهى.
وفي بعض خطب أمير المؤمنين عليه السلام : الحمد لله الّذي لا يموت،
ولا تنقضي عجائبه، لأنّه كلّ يوم [هو] في شأن، من إحداث بديع لم يكن، الّذي لم يلد فيكون في العزّ مشاركا، ولم يولد فيكون موروثا هالكا(١) ، ولم تقع عليه الأوهام فتقدّره شبحا ماثلا، ولم تدركه الأبصار فيكون بعد انتقالها حائلا، الّذي ليست في أوّليّته نهاية، ولا لآخريّته(٢) حدّ ولا غاية إلى آخره(٣) .
وفي رواية عن عليّ بن الحسين عليهما السلام :( لَمْ يَلِدْ ) لم يخرج منه شيء كثيف كالولد وسائر الأشياء الكثيفة الّتي تخرج من المخلوقين، ولا شيء لطيف كالنفس، ولا تنشعب منه البدوات كالسنة، والنوم، والخطرة، والهمّ، والحزن، والبهجة، والضحك، والبكاء، والخوف، والرجاء، والرغبة، والسآمة، والجوع، والشبع ؛ تعالى عن أن يخرج منه شيء، وأن يتولّد منه شيء كثيف أو لطيف.
و( لَمْ يُولَدْ ) لم يتولّد من شيء، ولم يخرج من شيء ؛ كما تخرج الأشياء الكثيفة من عناصرها كالشيء من الشيء، والدابّة من الدابّة، والنبات من الأرض، والماء من الينابيع، والثمار من الأشجار، ولا كما تخرج الأشياء من الأشياء اللطيفة من مراكزها كالبصر من العين، والسمع من الأذن، [والشمّ من الأنف]، والذوق من الفم، والكلام من اللسان، والمعرفة والتمييز من القلب، وكالنار من الحجر، لا بل هو الله الصمد الّذي لا من شيء، ولا في
__________________
(١) في البحار : «لم يولد فيكون في العزّ مشاركا، ولم يلد فيكون مورثا هالكا» ٤ : ٢٦٥.
(٢) في النسخة الحجريّة : في آخريّته.
(٣) الكافي ١ : ١٤١.
شيء، ولا على شيء، مبدع الأشياء وخالقها، ومنشئ الأشياء بقدرته، يتلاشى ما خلق للفناء بمشيّته، ويبقى ما خلق للبقاء بعلمه، فذلكم الله الصمد الّذي لم يلد، ولم يولد، عالم الغيب والشهادة، الكبير المتعال، لم يكن له كفوا أحد(١) . انتهى.
وفيه دلالة واضحة على أنّ المراد بالولادة هو خروج شيء عن آخر مطلقا، وامتناعها على الله، لإيجابها التغيير والحدوث، تعالى [الله] عن ذلك علوّا كبيرا.
وفي رواية وهب المتقدّمة(٢) يقول :( لَمْ يَلِدْ ) عزّ وجلّ فيكون له ولد يرثه ملكه( وَلَمْ يُولَدْ ) فيكون له والد يشركه في ربوبيّته وملكه إلى آخره.
وفي رواية يعقوب السرّاج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنّ بعض أصحابنا يزعم أنّ لله صورة مثل الإنسان، وقال آخر : إنّه في صورة أمرد جعد قطط، فخرّ أبو عبد الله ساجدا ثمّ رفع رأسه فقال : سبحان الله الّذي ليس كمثله شيء، ولا تدركه الأبصار، ولا يحيط به علم،( لَمْ يَلِدْ ) لأنّ الولد يشبه أباه،( وَلَمْ يُولَدْ ) فيشبه من كان قبله( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ) من خلقه( كُفُواً أَحَدٌ ) تعالى عن صفته من سواه علوّا كبيرا(٣) . انتهى.
وفي الكشّاف :( لَمْ يَلِدْ ) لأنّه لا يجانس حتّى تكون له من جنسه صاحبة فيتوالدا وقد دلّ على ذلك المعنى بقوله تعالى( أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ
__________________
(١) بحار الأنوار ٣ : ٢٢٣، مجمع البيان ٥ : ٨٦١.
(٢) أي في رواية وهب بن وهب القرشيّ. بحار الأنوار ٣ : ٢٢٤، التوحيد : ٩٢.
(٣) التوحيد : ١٠٣، بحار الأنوار ٣ : ٣٠٤.
تَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ ) (١) ( وَلَمْ يُولَدْ ) لأنّ كلّ مولود محدث وجسم، وهو قديم لا أوّل لوجوده وليس بجسم(٢) . انتهى.
وفي أنوار التنزيل للبيضاويّ :( لَمْ يَلِدْ ) لأنّه لم يجانس ولم يفتقر إلى ما يعينه أو يخلف عنه، لامتناع الحاجة والفناء عليه. ولعلّ الاقتصار على لفظ الماضي لوروده ردّا على من قال : الملائكة بنات الله، أو المسيح ابن الله، أو ليطابق قوله( وَلَمْ يُولَدْ ) وذلك لأنّه لا يفتقر إلى شيء، ولا يسبقه عدم(٣) . انتهى.
والظاهر أنّ وجه الاقتصار أنّ العلّيّة في عدم الولادة سابقا جارية فيما بعد وهي امتناع التغيير والحدوث عليه، وقد ردّ الله على قريش في قولهم : إنّ الملائكة بنات الله، وإنّه صاهر الجنّ فخرجت الملائكة بقوله تعالى في سورة الصافّات :( فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَناتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ * أَمْ خَلَقْنَا الْمَلائِكَةَ إِناثاً وَهُمْ شاهِدُونَ * أَلا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ * وَلَدَ اللهُ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ * أَصْطَفَى الْبَناتِ عَلَى الْبَنِينَ * ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ * أَفَلا تَذَكَّرُونَ * أَمْ لَكُمْ سُلْطانٌ مُبِينٌ * فَأْتُوا بِكِتابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ * وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ * سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ ) (٤) .
وقد حكى عن الجنّ أنّهم قالوا : إنّه( مَا اتَّخَذَ صاحِبَةً وَلا وَلَداً ) (٥) .
__________________
(١) الأنعام، ١٠١.
(٢) الكشّاف ٤ : ٨١٨.
(٣) أنوار التنزيل وأسرار التأويل ٢ : ٦٣١.
(٤) الصافّات : ١٤٩ ـ ١٥٩.
(٥) الجنّ : ٣.
وقال عزّ وجلّ في سورة الأنعام :( وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَناتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يَصِفُونَ * بَدِيعُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) (١) .
وحاصل هذه الآية، أنّه لم يخرج منه شيء كخروج شيء من شيء، ولم يخرج من شيء كذلك، فإنّ ذلك كلّه من صفات الحوادث، فباب الواجب بالذات مسدود لا يدخل فيه شيء، ولا يخرج منه شيء، فيمتنع الواجب القديم من أن يخرج منه شيء، أو يخرج من شيء، وإلّا لزم المشابهة والمجانسة والمشاكلة ؛ تعالى [الله] عن ذلك علوّا كبيرا.
فإن قيل : فإذا كان الله تعالى لم يلد ولم يولد ولن يلد لما ذكر من العلّة لزم أن يمتنع صدور الممكنات عنه، مع أنّه موجدها ومبدعها بالضرورة، وهو خالق كلّ شيء بقدرته.
قلت أوّلا : إنّ صدور فعل عن فاعل لا يسمّى ولادة.
وثانيا : إنّ الربط بين الفاعل والفعل والمفعول إنّما يتصوّر فيما [إذا] كان الفاعل حادثا، وحينئذ يكون بينه وبين أثره ربط لمكان المجانسة والمشابهة والمشاكلة، وأمّا القديم تعالى فلا ضدّ له، ولا شيء يشبهه ويجانسه، كيف وهو الواحد المتفرّد في أزليّته بحيث لا يشبهه شيء، ولا يوافقه شيء، ولا يخالفه شيء، ولا ضدّ ولا ندّ ولا شريك له، ولا هو من شيء، ولا في شيء، ولا كشيء، ولا عن شيء، ولا منه شيء، فلا مناسبة بينه وبين شيء من الممكنات، ولا رابطة ولا نسبة بينهما، فإنّ تحقّق النسبة فرع وجود
__________________
(١) الأنعام : ١٠٠، ١٠١.
المنتسبين وتحقّقهما، فهي إمّا حادثة فيلزم كونه تعالى محلّا للحادث، وإمّا قديمة فيلزم قدم الخلق وتعدّد القدماء، وكلا اللازمين باطل بالضرورة.
نعم تكون المناسبة بين فعل وأثره وخلقه. قيل : لأنّه إنّما أوجد الموجودات بفعله لا بذاته، ولفعله رؤوس ؛ كلّ رأس يختصّ بموجود من الموجودات، فهو ملك له رؤوس بعدد رؤوس الخلائق ممّا وجد، وممّا لم يوجد، وسيوجد إلى يوم القيامة، وبعده إلى ماشاء الله. فأوجد الموجودات بفعله وخلقه بنفسه، فكان الفعل في أوّل ظهوره نقطة جوهريّة لا تقبل القسمة أبدا في جميع الجهات لا فرضا ولا عقلا ولا وهما، ثمّ حرّكها الله بنفسها فصارت «ألفا» قابلة للقسمة في الطول، لا في العرض، فهذه «الألف» هي النقطة، ثمّ حرّكها الله بتحريكها بنفسها فصارت «حروفا غاليات» ثمّ جمع بين الحروف المتفرّقة فصارت «كلمة» فأنزل من سحاب تلك الكلمة «ماء الدلالة» وهي الظهور والتجلّي للخلق بالخلق على أرض القابليّات، فنبتت شجرة الوجود المقيّد، فكلّ الموجودات ثمرات تلك الشجرة وأغصانها وأوراقها، فالرابطة إنّما تكون بين الحادث والحادث، لا بينه وبين القديم تعالى، فإنّه منزّه عنها وعن المشابهات والمجانسات، فالآثار كلّها صادرة عن فعله تعالى لا عن ذاته، وفعله صادر عن نفس ذلك الفعل.
كما قال عليه السلام : خلق الأشياء بالمشيّة، وخلق المشيّة بنفسها(١) .
وبعبارة أخرى : الأشياء كلّها مرتبطة بفعله، وفعله مرتبط بنفس هذا الفعل ؛ إذ ليس قبله مثل حتّى يرتبط به، ولا معه غيره حتّى يكون مرتبطا به.
__________________
(١) في الكافي ١ : ١١٠ : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «خلق الله المشيّة بنفسها، ثمّ خلق الأشياء بالمشيّة».
قال بعض المشايخ : والحاصل إنّ الذات البحت لا يجوز أن تكون علّة لشيء إلّا على المعنى الّذي قرّرنا من أنّ الأشياء كلّها تنتهي إلى فعله، وفعله ينتهي إلى نفسه ؛ أي نفس الفعل.
وإليه الإشارة بقول أمير المؤمنين عليه السلام : انتهى المخلوق إلى مثله، وألجأه الطلب إلى شكله، الطلب مردود، والطريق مسدود، ولو فرض أنّ ذاته تعالى علّة لشيء، لوجب أن يكون هيئته مشابهة لهيئة ذاته، لأنّ المعلول أثر، والأثر يشابه صفة مؤثّره ؛ كما ترى من مشابهة هيئة الكتابة، فإنّها تشابه صفة حركة يد الكاتب، ولا تشابه شيئا من صفات الكاتب، فلا تدلّ على قوّته وضعفه، ولا على بياضه وسواده، ولا على سعادته وشقاوته، ولا على طوله أو قصره. وهكذا.
ولو كان بين الكتابة وبين ذات الكاتب مناسبة لدّلت الكتابة بهيئتها على شيء من صفات ذات الكاتب، فلمّا لم تكن بينهما مناسبة بوجه من الوجوه دلّ على عدم الربط، إلى أن قال : فمن عرف ما قلنا حصل له القطع بعدم الربط بين الأثر والذات.
وبيانه : أنّ «السراج» ضربه الله مثلا تامّا فيما نحن فيه، فالنار آية الواجب عزّ وجلّ، وحرارة النار آية المشيّة الّتي هي فعل الله، وآية نور محمّد صلّى الله عليه وآله الدهن المتكلّس بحرارة النار حتّى صار دخانا واستنار ذلك الدهن بتلك الحرارة، لأنّ نور محمّد صلّى الله عليه وآله يكون بفعل الله كما استنار الدخان بحرارة النار في السراج، والأشعّة المنبعثة من آية الأشياء الموجودة من نور محمّد صلّى الله عليه وآله فكما أنّ الأشعّة لا ربط بينها وبين النار الّتي هي الحرارة واليبوسة الجوهريّان ؛ إذ لا يؤثّر فيها، وإنّما الربط بين الأشعّة
وبين الشعلة الّتي هي الدخان المنفعل بالاستضاءة عن حرارة النار، كذلك لا ربط بين الحوادث وبين المعبود بالحقّ عزّ وجلّ، وإنّما الربط بين الحوادث وبين فعل الله الّذي آيته حرارة النار، والمتعلّق به الّذي هو نور محمّد صلّى الله عليه وآله آيته الدهن المتكلّس حتّى صار دخانا واستضاء بحرارة النار، فخلق الله من شعاعه حقائق الأشياء الّتي آيتها شعاع السراج الواقع على الأرض والجدر، فإنّ الله خلقه من شعاع الشعلة المرئيّة من السراج.
ومن المعلوم المقطوع به أنّ الربط متحقّق بين الأشعّة الواقعة على الأرض والجدر وبين الشعلة المرئيّة الّتي هي الدخان المتكلّس من الدهن بحرارة النار ؛ استنير من حرارتها، وبين الأشعة بعضها بالنسبة إلى بعض لا غير ذلك، وليس بينها وبعضها وبين النار ربط في حال من الأحوال، ولا نسبة ولا تعلّق، وهذا آية ما نحن فيه فتفهّم. انتهى كلامه.
وللحكماء في مسألة الربط بين القديم والحادث كلمات مختلفة، والأولى أن نطوي الكشح عن التحقيق في هذه المسألة، وظنّي أنّها من السرّ المستسرّ، والسرّ المقنّع بالسرّ، فإنّ غاية ما ندركه في المقام هو إيجاده وخلقه، وأمّا كيفيّة ذلك وحقيقته فلا يعلمها سوى الله ومن ارتضاه لعلمه ووحيه. ومرادنا ممّا ذكرناه في الجواب عن الإشكال المذكور : أنّ الذات من حيث إنّه ذات لا ينقص منه شيء، ولا يزيد عليه شيء فهو هو كما كان في الأزل والآن كما كان، وصدور الموجودات من مشيّته لا يوجب شيئا من ذلك سبحانه( سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يَصِفُونَ ) (١) .
__________________
(١) الأنعام : ١٠٠.
الآية الخامسة :
قوله تعالى( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ) قدّم المسند على المسند إليه، لأنّ الغرض الأصليّ من عقد هذه الجملة نفي الكفو، فيكون أهمّ كما أنّ المسند إليه قد يقدّم لذلك.
لا يقال : إنّ ما لم يكن في الماضي يمكن أن يكون في المستقبل فـ «لم يكن» لا ينافيه «يكون» لما عرفته في جواب السؤال عن أنّ «لم يلد» لا ينافيه «يلد» في المستقبل من أنّ العلّة الثابتة في الماضي جارية في المستقبل، هذا مع أنّ الماضي والمستقبل بالنسبة إلى الحقّ القديم سيّان، كيف وهو خالق الزمان ومبدع أسبابه من الأفلاك وحركاتها، فتأمّل.
وهذا السؤال لا يجري في( وَلَمْ يُولَدْ ) فإنّ الموجود إذا كان لم يولد امتنع أن يولد ؛ بمعنى أن يوجد بالولادة بعد فرضه موجودا بنفسه، وإنّما يصحّ ذلك في المعدوم سابقا، والحقّ القديم أزليّ غير مسبوق بالعدم بالضرورة، وفي المقام سؤال آخر وهو أنّ «له» ظرف لغو لتعلّقه بـ «كفوا».
وقد نصّ سيبويه على أنّ الظرف الّذي هو غير مستقرّ يؤخّر في الكلام العربيّ الفصيح ولا يقدّم، فكيف قدّم في هذا الكلام مع كونه أفصح الكلام؟! وقد نقل : إنّ بعض العرب كان يقرأ «ولم يكن أحد كفوا له»(١) .
وقد أجاب عنه الزمخشريّ في الكشّاف بأنّ هذا الكلام إنّما سيق لنفي المكافأة عن ذات الباري سبحانه، وهذا المعنى مصبّه ومركزه هو هذا
__________________
(١) انظر : الكشّاف ٤ : ٨١٨.
الظرف، فكان لذلك أهمّ شيء وأعناه وأحقّه بالتقدّم وأحراه(١) .
وإلى هذا يرجع ما ذكره آخر من أنّ الغرض الّذي سيقت له الآية نفي المكافأة والمساواة عن ذات الله، فكان تقديم المكافأة المقصود بأن يسلب عنه أولى. قال : ثمّ لمـــّـا قدّمت لتسلب ذكر معها الظرف ليبيّن الذات المقدّسة بسلب المكافأة. انتهى.
وفي تفسير البيضاويّ : وكان أصله أن يؤخّر الظرف لأنّه صلة «كفوا» ؛ لكن لمـــّـا كان المقصود نفي المكافأة عن ذاته تعالى قدّم تقديما للأهمّ، ويجوز أن يكون حالا من المستكنّ في «كفوا» أو خبرا(٢) إلى آخره.
و «الكفو» بضمّ الكاف والفاء، وبضمّ الكاف وسكون الفاء، وبكسر الكاف وسكون الفاء، وكلّ ذلك بالواو في آخره، أو الهمزة بقلبها «واوا» في الأوّل : المثل والنظير، والمصدر «الكفاءة» بالفتح والمدّ، ويقال : «لا كفأ له» بالكسر ؛ أي لا نظير له، ويقال : هذان متكافئان ؛ أي متساويان، قال :
الناس من جهة التمثال أكفاء
أي : أمثال وأشباه.
وفي تفسير الصادقيّ :( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ) يقول ليس له شبه، ولا مثل، ولا عديل، ولا يكافئه أحد من خلقه بما أنعم عليه من فضله. انتهى.
وفي الكلام الأخير دلالة على أنّه يراد أيضا بنفي الكفو المكافأة والمجازاة بالإحسان، فإنّ نعماءه لا تحصى، وآلاءه لا تستقصى، ومواهبه لا تجازى، فتدبّر.
__________________
(١) الكشّاف ٤ : ٨١٨ ـ ٨١٩.
(٢) أنوار التنزيل وأسرار التأويل ٢ : ٦٣١.
ويحتمل أن يكون من الكفاءة في النكاح، فتكون هذه الجملة تقريرا لما تدلّ عليه السابقة من أنّه تعالى لم يلد، فإنّه لو صحّ له ذلك لزم أن تكون له صاحبة كفوا له وليست البتّة.
وفي حديث وهب( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ) فيعازه في سلطانه(١) . انتهى ؛ أي فيخاصمه فيه.
وفي رواية المفضّل بن عمر عن الصادق عليه السلام قال : من شبّه الله بخلقه فهو مشرك، إنّ الله تبارك وتعالى لا يشبه شيئا، ولا يشبهه شيء، وكلّما وقع في الوهم فهو بخلافه(٢) .
قال الصدوق رحمه الله في توحيده : الدليل على أنّ الله سبحانه لا يشبه شيئا من خلقه من جهة من الجهات أنّه لا جهة لشيء من أفعاله إلّا محدثة، ولا جهة محدثة إلّا وهي تدلّ على حدوث من هي له، فلو كان الله جلّ ثناؤه يشبه شيئا منها لدلّت على [حدوثه من حيث دلّت على](٣) حدوث من هي له(٤) ، إذ المتماثلان في العقول يقتضيان حكما واحدا من حيث تماثلا منها(٥) ، وقد قام الدليل على أنّ الله عزّ وجلّ قديم، ومحال أن يكون قديما من جهة وحادثا من اخرى، ومن الدليل على أنّه تعالى(٦) قديم أنّه لو كان حادثا لوجب أن
__________________
(١) التوحيد : ٩٢.
(٢) بحار الأنوار ٣ : ٢٩٩.
(٣) أضفناه من المصدر.
(٤) أي : لو كان يشبه شيئا من أفعاله لكان له جهة محدثة، ولدلّت تلك الجهة على حدوثه كما دلّت على حدوث من هي له.
(٥) أي : من جهة من الجهات.
(٦) في المصدر : أنّ الله تبارك وتعالى.
يكون له محدث، لأنّ الفعل لا يكون إلّا بفاعل، ولكان القول في محدثه كالقول فيه، وفي هذا وجود حادث قبل حادث [لا إلى أوّل، وفي هذا محال](١) فصحّ أنّه لا بدّ من صانع قديم، وإذا كان [ذلك](٢) كذلك، فالّذي يوجب قدم ذلك الصانع ويدلّ عليه يوجب قدم صانعنا [ويدلّ عليه](٣) .(٤) انتهى.
وبالجملة : هذه الآية ظاهرة الدلالة على مقام واحديّته، وأنّه لا يشبهه شيء في ألوهيّته، ولا يشاركه أحد في هويّته، ووجوب وجوده، وقدم ذاته ؛ كما أنّ الآية الثانية دالّة على أحديّته، وأنّه بسيط الحقيقة، ليس له أجزاء خارجيّة ولا ذهنيّة.
وفي رواية أبي هاشم الجعفريّ قال : سألت أبا جعفر محمّد بن عليّ الثاني : ما معنى الواحد؟ فقال عليه السلام : المجتمع عليه بجميع الألسن بالوحدانيّة(٥) .
وفي روايته الأخرى قال عليه السلام : الّذي اجتماع الألسن عليه بالتوحيد ؛ كما قال الله عزّ وجلّ :( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ ) (٦) .(٧)
وفي بعض خطب عليّ بن موسى عليه السلام : الحمد لله الملهم عباده الحمد، وفاطرهم على معرفة ربوبيّته، الدالّ على وجوده بخلقه، وبحدوث
__________________
(١) أضفناه من المصدر.
(٢) أضفناه من المصدر.
(٣) أضفناه من المصدر.
(٤) التوحيد : ٨٠ ـ ٨١. ومعنى العبارة الأخيرة فيه : أي يوجب أن يكون صانعنا القديم الّذي كلامنا فيه ذلك الصانع القديم الّذي اضطرّ العقل إلى إثباته.
(٥) بحار الأنوار ٣ : ٢٠٨.
(٦) الزخرف : ٨٧.
(٧) بحار الأنوار ٣ : ٢٠٨.
خلقه على أزليّته، وبأشباههم على أن لا شبه له، المستشهد بآياته على قدرته، الممتنع من الصفات ذاته، ومن الأبصار رؤيته، ومن الأوهام الإحاطة به، لا أمد لكونه، ولا غاية لبقائه(١) إلى آخره.
خاتمة :
في بيان أمرين :
الأوّل :
في وجه تسمية هذه السورة المباركة بأسمائها المعروفة.
فمنها : سورة «الإخلاص» سمّيت بها لاشتمالها على تنزيه الحقّ تعالى عن التركيب والشبيه والشريك، فيكون قارئها سليم القلب عن الشرك، وخالصه عن التوجّه إلى غير الحقّ المعبود قائلا بما قاله الخليل عليه السلام :( يا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ * إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) (٢) .
ومنها : سورة «التوحيد» لاشتمالها على التوحيد الّذي أمر الله عباده به.
وقد روي عن أبن أبي عمير أنّه قال : دخلت على سيّدي موسى بن جعفر عليهما السلام فقلت له : يا ابن رسول الله، علّمني التوحيد! فقال : يا أبا أحمد، لا تتجاوز في التوحيد ما ذكره الله تعالى في كتابه فتهلك، واعلم أنّ الله تبارك وتعالى واحد أحد صمد لم يلد فيورث، ولم يولد فيشارك، ولم يتّخذ
__________________
(١) بحار الأنوار ٤ : ٢٨٤.
(٢) الأنعام : ٧٨ و ٧٩.
صاحبة ولا ولدا ولا شريكا، وأنّه الحيّ الّذي لا يموت(١) إلى آخره.
وروي أنّه سئل الصادق عليه السلام عن التوحيد فقال : إنّ الله عزّ وجلّ علم أنّه سيكون(٢) في آخر الزمان أقوام متعمّقون فأنزل الله( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) والآيات من سورة الحديد إلى قوله( عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ ) (٣) فمن رام وراء ذلك فقد هلك(٤) .
وروي أنّه سئل الرضا عن التوحيد، فقال : كلّ من قرأ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) وآمن بها فقد عرف التوحيد، قيل : كيف يقرؤها؟ [قال : كما يقرؤها] الناس، وزاد فيها : كذلك الله ربّي ـ مرّتين(٥) .
وعن الفضيل أنّ أبا جعفر عليه السلام أمرني أن أقرأ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) فأقول إذا فرغت منها : كذلك الله ربّي ثلاثا(٦) .
ومنها : سورة «الأساس» لاشتمالها على ما عليه أساس الدين ؛ بل أساس الوجود كلّه، وهو التوحيد الّذي جوهره : أن لا متأصّل ولا مؤثّر في الوجود
__________________
(١) بحار الأنوار ٤ : ٢٩٦.
(٢) في المصدر : يكون.
(٣) الحديد : ٦.
(٤) الكافي ١ : ٩١.
(٥) بحار الأنوار ٣ : ٢٦٨.
وروي أنّه سئل الرضا عليه السلام عن التوحيد، فقال : كلّ من قرأ ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) وآمن بها فقد عرف التوحيد، قلت : كيف يقرؤها؟ [قال : كما يقرؤها] الناس، وزاد فيها : كذلك الله ربّي، كذلك الله ربّي، كذلك الله ربّي.
(٦) بحار الأنوار ٨٥ : ٦٠.
وعن الفضيل بن يسار قال : أمرني أبو جعفر عليه السلام أن أقرأ ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) فأقول إذا فرغت منها : كذلك الله ربّي ثلاثا.
حقيقة سوى الحقّ المعبود بالحقّ.
ومن هنا روي عن النبيّ صلّى الله عليه وآله أنّه قال : أسّست السماوات السبع والأرضون السبع على( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) (١) .
قال الزمخشريّ في الكشّاف : يعني ما خلقت إلّا لتكون دلائل على توحيد الله ومعرفة صفاته الّتي نطقت بها هذه السورة(٢) . انتهى.
ويحتمل أن يراد به أن لو يكن الله واحدا بلا شريك لاختلّ نظام العالم ؛ كما أشار إليه بقوله تعالى :( لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا ) (٣) .
وروي عن هشام بن الحكم أنّه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما الدليل على أنّ الله واحد؟ قال : اتّصال التدبير، وتمام الصنع ؛ كما قال عزّ وجلّ :( لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا ) (٤) انتهى.
ومنها : سورة «نسبة الربّ» كما في باب النوادر من كتاب الصلاة من الكافي ؛ في رواية الصادق عليه السلام قال : إنّ الله عزّ وجلّ لمـــّـا عرج بنبيّه صلّى الله عليه وآله إلى سماواته السبع ؛ أمّا أولاهنّ فبارك عليه، والثانية علّمه فرضه ـ إلى أن قال ـ : أوحى الله إليه سمّ باسمي ؛ فمن أجل ذلك جعل «بسم الله الرحمن الرحيم» في أوّل السورة، إلى قوله : ثمّ أوحى الله إليه : اقرأ يا محمّد نسبة ربّك تبارك وتعالى( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ * اللهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ) .
__________________
(١) انظر : الكشّاف ٤ : ٨١٩.
(٢) الكشّاف ٤ : ٨١٩.
(٣) الأنبياء : ٢٢.
(٤) بحار الأنوار ٣ : ٢٢٩.
ثمّ أمسك عنه الوحي، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : الواحد الأحد الصمد فأوحى الله إليه( لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ) .
ثمّ أمسك عنه الوحي، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : كذلك [الله](١) ربّنا، فلمّا قال ذلك، أوحى الله إليه : اركع لربّك يا محمّد! فركع.
إلى أن قال : ثمّ أوحى الله إليه اقرأ( إِنَّا أَنْزَلْناهُ ) فإنّها نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة(٢) إلى آخره.
سمّيت بذلك لما روي من أنّ اليهود سألوا رسول الله صلّى الله عليه وآله فقالوا : انسب لنا ربّك! فلبث ثلاثا لا يجيبهم، ثمّ نزلت( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) (٣) إلى آخرها.
قوله «ثلاثا» ؛ أي ثلاث ساعات، أو ثلاث ليال وأيّام، فالتأنيث لمكان الليالي، ولعلّ الوجه في تأخير الجواب مع علمه صلّى الله عليه وآله به قطعا انتظار نزول قرآن في ذلك ليكون حجّة باقية إلى يوم القيامة على أهل الشكوك والشبهات ممّن ينتحل الإسلام.
وفي رواية أخرى : أنّ الصادق عليه السلام سئل عن( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) فقال عليه السلام : نسبة الله إلى خلقه أحدا صمدا أزليّا صمديّا لا ظلّ له يمسكه وهو يمسك الأشياء بأظلّتها(٤) إلى آخره.
قال في القاموس : النسب محرّكة والنسبة بالكسر وبالضمّ : القرابة، أو
__________________
(١) ليست في الأصل.
(٢) الكافي ٣ : ٤٨٢ ـ ٤٨٦.
(٣ و ٤) الكافي ١ : ٩١.
في الآباء خاصّة، واستنسب : ذكر نسبه، والنسيب : المناسب، وذو النسب كالمنسوب، ونسبه ينسبه وينسبه نسبا محرّكة ونسبة بالكسر : ذكر نسبه، وسأله أن ينتسب.
إلى أن قال : والنيسب كـ «حيدر» الطريق المستقيم الواضح كالنيسبان أو ما وجد من أثر الطريق، والنمل إذا جاء منها واحد في إثر آخر، وطريق للنمل(١) إلى آخره.
والظاهر من النسبة في المقام هو المعنى الأوّل، والمراد نفي النسبة عنه تعالى، ولكن صرّح بعض الأفاضل بأنّ المراد بها الصراط المستقيم والطريق الواضح إلى معرفته تعالى، وللتأمل فيه مجال.
الأمر الثاني :
في الإشارة إلى بعض فضائل هذه السورة.
فنقول : إنّ الأخبار في فضائلها أكثر من أن تحصى ؛ ففي بعضها : أنّها تعدل القرآن كلّه.
قال في الكشّاف : فإن قلت : لم كانت هذه السورة تعدل القرآن كلّه على قصر متنها وتقارب طرفيها؟
قلت : لأمر ما يسود من يسود، وما ذاك إلّا لاحتوائها على صفات الله تعالى وعدله وتوحيده، وكفى دليلا من اعترف بفضلها، وصدّق بقول رسول الله صلّى الله عليه وآله فيها : إنّ علم التوحيد من الله بمكان، وكيف لا
__________________
(١) انظر : الكشّاف ٤ : ٨١٨، القاموس المحيط ١ : ١٣٦.
يكون كذلك والعلم تابع للمعلوم ؛ يشرف بشرفه، ويتّضع بضعته، ومعلوم أنّ هذا العلم هو الله تعالى وصفاته، وما يجوز عليه وما لا يجوز، فما ظنّك بشرف منزلته، وجلالة محلّه، وإنافته على كلّ علم، واستيلائه على قصب السبق دونه، ومن ازدراه فلضعف علمه بمعلومه، وقلّة تعظيمه له، وخلوّه من خشيته، وبعده من النظر لعاقبته(١) . انتهى.
وفي بعضها : إنّها تعدل ثلث القرآن(٢) .
قال البيضاويّ : ولاشتمال هذه السورة مع قصرها على جميع المعارف الإلهيّة والردّ على من ألحد فيها، جاء في الحديث : إنّها تعدل ثلث القرآن. فإنّ مقاصده محصورة في بيان العقائد والأحكام والقصص، ومن عدلها بكلّه اعتبر المقصود بالذات من ذلك(٣) . انتهى.
وهذا الجمع حسن كما لا يخفى.
ويمكن أن يقال : إنّ القرآن لمـــّـا كان مشتملا على تمام العلوم ؛ وقد ورد أنّ العلوم ثلاثة آية محكمة، وفريضة عادلة، وسنّة قائمة(٤) .
و [إذا] فسّر «الآية المحكمة» بالتوحيد، كانت هذه السورة لاشتمالها على التوحيد تعدل ثلث القرآن، ولكن المقصود الأصليّ من جميع هذه العلوم هو التوحيد، [فلذلك] عدلت القرآن كلّه.
__________________
(١) الكشّاف ٤ : ٨١٩.
(٢) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أبي عليه السلام يقول : «قل هو الله أحد» تعدل ثلث القرآن، وكان يحبّ أن يجمعها في الوتر ليكون القرآن كلّه. التهذيب ٢ : ١٢٧.
(٣) أنوار التنزيل وأسرار التأويل ٢ : ٦٣١.
(٤) إشارة إلى رواية معروفة جاءت في الكافي ١ : ٣٢.
وفي بعض الروايات عن النبيّ صلّى الله عليه وآله أنّه من قرأ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) مرّة بورك عليه، فإن قرأها مرّتين بورك عليه وعلى أهله، فإن قرأها ثلاث مرّات بورك عليه وعلى أهله وعلى جميع جيرانه، فإن قرأها اثنتي عشرة مرّة بني له اثنا عشر قصرا في الجنّة، فيقول الحفظة : انطلقوا بنا ننظر إلى قصر أخينا، فإن قرأها مائة مرّة كفّر عنه ذنوب خمس وعشرين سنة ما خلا الدماء والأموال، فإن قرأها أربعمائة كفّر عنه ذنوب أربعمائة سنة، فإن قرأها ألف مرّة لم يمت حتّى يرى مكانه في الجنّة، أو يرى له(١) . انتهى.
وروى الصدوق في المجالس بسنده إلى أحمد عن هلال، عن عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جدّه، عن آبائه، عن عليّ عليه السلام [قال :] قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : من قرأ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) حين يأخذ مضجعه غفر له ذنوب خمسين سنة(٢) .
وروى أيضا بسنده إلى شعيب عن أبي بصير قال : سمعت الصادق عليه السلام جعفر بن محمّد عليهما السلام يحدّث عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال :
__________________
(١) جاء هذا الحديث في الكافي ٢ : ٦١٢ مع اختلاف في بعض الألفاظ، هكذا : عن أبي جعفر عليه السلام قال : من قرأ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) مرّة بورك عليه، ومن قرأها مرّتين بورك عليه وعلى أهله، ومن قرأها ثلاث مرّات بورك عليه وعلى أهله وعلى جيرانه، ومن قرأها اثني عشر مرّة بنى الله له اثني عشر قصرا في الجنّة، فيقول الحفظة : اذهبوا بنا إلى قصور أخينا فلان فننظر إليها، ومن قرأها مائة مرّة غفرت له ذنوب خمسة وعشرين سنة ما خلا الدماء والأموال، ومن قرأها أربعمائة كان له أجر أربعمائة شهيد كلّهم قد عقر جواده، وأريق دمه، ومن قرأها ألف مرّة في يوم وليلة لم يمت حتّى يرى مقعده في الجنّة، أو يرى له.
(٢) بحار الأنوار ٧٦ : ١٩٢، الأمالي، للصدوق : ٢٢.
قال رسول الله صلّى الله عليه وآله يوما لأصحابه : أيّكم يصوم الدهر؟
فقال سلمان رحمه الله : أنا يا رسول الله!
قال صلّى الله عليه وآله : فأيّكم يحيي الليل؟
قال سلمان : أنا يا رسول الله!
قال صلّى الله عليه وآله : فأيّكم يختم القرآن في كلّ يوم؟
فقال سلمان : أنا يا رسول الله!
فغضب بعض أصحابه ؛ فقال : يا رسول الله، إنّ سلمان رجل من الفرس يريد أن يفتخر علينا معاشر قريش، قلت أيّكم يصوم الدهر؟ فقال : أنا وهو أكثر أيّامه يأكل، وقلت : أيّكم يحيي الليل؟ فقال : أنا وهو أكثر ليلته نائم، وقلت : أيّكم يختم القرآن في كلّ يوم؟ فقال : أنا وهو أكثر نهاره صامت.
فقال النبي صلّى الله عليه وآله : مه يا فلان، أنّى لك بمثل لقمان الحكيم؟! سله فإنّه ينبئك.
فقال الرجل لسلمان : يا أبا عبد الله، أليس زعمت أنّك تصوم الدهر؟
فقال : نعم.
فقال : رأيتك في أكثر نهارك تأكل.
فقال : ليس حيث تذهب، إنّي أصوم الثلاثة في الشهر وقال الله عزّ وجلّ :( مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها ) (١) وأصل شعبان بشهر رمضان، فذاك صوم الدهر.
فقال : أليس زعمت أنّك تحيي الليل؟
__________________
(١) الأنعام : ١٦٠.
فقال : نعم.
فقال : أنت أكثر ليلتك نائم.
فقال : ليس حيث تذهب، ولكنّي سمعت حبيبي رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول : من بات على طُهْرٍ فكأنّما أحيا الليل كلّه. فأنا أبيت على طهر.
فقال : أليس زعمت أنّك تختم القرآن في كلّ يوم؟
قال : نعم.
قال : فأنت أكثر أيّامك صامت.
فقال : ليس حيث تذهب، ولكنّي سمعت حبيبي رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول لعلي عليه السلام : يا أبا الحسن، مثلك في أمّتي مثل( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) فمن قرأها مرّة فقد قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرّتين فقد قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأها ثلاثا فقد ختم القرآن، فمن أحبّك بلسانه فقد كمل له ثلث الإيمان، ومن أحبّك بلسانه وقلبه فقد كمل له ثلثا الإيمان، ومن أحبّك بلسانه وقلبه ونصرك بيده فقد استكمل الإيمان، والّذي بعثني بالحقّ يا عليّ! لو أحبّك أهل الأرض كمحبّة أهل السماء لك لما عذّب أحدٌ بالنار! وأنا أقرأ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) في كلّ يوم ثلاث مرّات.
فقام وكأنّه قد ألقم حجرا(١) .
فالحمد لله أوّلا وآخرا، والصلاة على رسوله ظاهرا وباطنا.
قد تمّ في الثاني من المحرّم سنة ١٣٢٧ ه.
__________________
(١) بحار الأنوار ٢٢ : ٣١٧، و ٧٦ : ١٨١.
فهرس موضوعات الكتاب
ترجمة المفسّر : ٥
سورة الفاتحة ٧
الجنّة الثانية : في إعرابها ١٧
الجنّة الثالثة : في بيان اشتقاق الاسم ١٨
الجنّة الرابعة : في الفرق بين الاسم والمسمّى والتسمية ١٩
فرع : ٢٩
خاتمة : ٣١
الجنّة الخامسة : في بيان بعض ما يتعلّق بالاسم الأعظم «الله» ٣٣
المخزن الأوّل : في بعض ما يخصّ «الله» به دون سائر الأسماء ٣٣
وأمّا الخصائص الباطنيّة فكثيرة أيضا : ٣٤
خاتمة : ٣٦
المخزن الثاني : في بيان اشتقاق الجلالة وذكر الخلاف وما يتعلّق بذلك ٣٧
الجنّة السادسة : في ما يتعلّق بالرحمن الرحيم ٤٠
المرصد الأوّل : في بعض خواصّهما ٤٠
المرصد الثاني : في كشف الحجاب عن معانيهما ٤٢
فائدتان : ٤٤
خاتمة : ٤٥
المقام الأوّل : في إعرابه وما يتعلّق به ٤٧
فائدة : ٥٠
فائدة أخرى : ٥١
خاتمة : ٥٢
المقام الثاني : في فضيلة الحمد لله والشكر له، وكيفيّة ذلك ٥٢
على ما يظهر من الأخبار ٥٢
المقام الثالث : في التفرقة بين الحمد والشكر والمدح على طريق الإجمال ٥٥
فائدة : ٥٧
خاتمة : ٥٨
المرصد الأوّل : في إعرابه ٥٩
المرصد الثاني : في معنى «الربّ» وما يتعلّق به ٦١
خاتمة : ٦٢
المرصد الثالث : في ذكر بعض كيفيّات تربيته تعالى لبعض الخلائق ٦٢
المقام الأوّل : في معناه وما يتعلّق به ٦٦
المقام الثاني : في ذكر بعض العوالم وما يتعلّق بذلك إجمالا ٦٩
فائدة : ٧٣
خاتمة : في بعض ما يتعلّق بـ ( الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) ٧٣
المقالة الأولى : في ما يتعلّق بإعرابه ٧٥
المقالة الثانية : في معنى «المالك» و «الملك» ٧٦
عائدة : ٧٧
الفرق بينهما أيضا ٧٧
المقالة الرابعة : في تفسير قوله ( يَوْمِ الدِّينِ ) ٨٠
المقالة الاولى : في إعرابه ٨٧
على طريق الإجمال ٨٩
المقالة الاولى : في إعرابه وما يتعلّق بذلك ٩١
المقالة الثانية : في معنى الهداية وما يتعلّق بذلك ٩١
فائدة : ٩٢
المقالة الثالثة : في معنى ( الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ ) ٩٣
المقالة الأولى : في ما يتعلّق بإعرابه ٩٥
المقالة الثانية : في معنى الفقرة ٩٧
سورة الفتح ٩٩
سورة الجمعة ٢٠٥
وجوه في الفرق بين الرسول والنبيّ : ٢٢٢
سورة الملك ٢٨٧
سورة الكوثر ٤٠١
سورة التوحيد ٤٢٧
الآية الأولى : البسملة ٤٢٩
الآية الثانية : ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ٤٣٠
[المقصد] الأوّل : في الأولى [وهي كلمة «قل»] ٤٣٠
المقصد الثاني : في الثانية : [وهي كلمة «هو»] ٤٣٢
المقصد الثالث : في الثالثة ٤٣٩
المقصد الرابع : في الرابعة : ٤٤٥
تذنيب : ٤٤٨
الآية الثالثة : ٤٥٢
[ما هو تفسير الصمد؟] ٤٥٢
الآية الرابعة : ٤٥٧
الآية الخامسة : ٤٦٥
خاتمة : ٤٦٩
الأوّل : ٤٦٩
الأمر الثاني : ٤٧٣
فهرس موضوعات الكتاب ٤٧٩