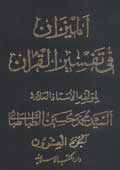( سورة الملك مكّيّة و هي ثلاثون آية)
( سورة الملك الآيات 1 - 14)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( 1 ) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ( 2 ) الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ( 3 ) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ( 4 ) وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ( 5 ) وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ( 6 ) إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ( 7 ) تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ( 8 ) قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ( 9 ) وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ( 10 ) فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ ( 11 ) إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ( 12 ) وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ( 13 ) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ( 14 )
( بيان)
غرض السورة بيان عموم ربوبيّته تعالى للعالمين تجاه قول الوثنيّة إنّ لكلّ شطر من العالم ربّاً من الملائكة و غيرهم و إنّه تعالى ربّ الأرباب فقط.
و لذا يعدّ سبحانه كثيراً من نعمه في الخلق و التدبير - و هو في معنى الاحتجاج على ربوبيّته - و يفتتح الكلام بتباركه و هو كثرة صدور البركات عنه، و يكرّر توصيفه بالرحمن و هو مبالغة في الرحمة الّتي هي العطيّة قبال الاستدعاء فقراً و فيها إنذار ينتهي إلى ذكر الحشر و البعث.
و تتلخّص مضامين آياتها في الدعوة إلى توحيد الربوبيّة و القول بالمعاد.
و السورة مكّيّة بشهادة سياق آياتها.
قوله تعالى: ( تَبارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) تبارك الشيء كثرة صدور الخيرات و البركات عنه.
و قوله:( الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ ) يشمل بإطلاقه كلّ ملك، و جعل الملك في يده استعارة بالكناية عن كمال تسلّطه عليه و كونه متصرّفاً فيه كيف يشاء كما يتصرّف ذو اليد فيما بيده و يقلّبه كيف يشاء فهو تعالى يملك بنفسه كلّ شيء من جميع جهاته، و يملك ما يملكه كلّ شيء.
فتوصيفه تعالى بالّذي بيده الملك أوسع من توصيفه بالمليك في قوله:( عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ) القمر: 55، و أصرح و آكد من توصيفه في قوله:( لَهُ الْمُلْكُ ) التغابن: 1.
و قوله:( وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) إشارة إلى كون قدرته غير محدودة بحدّ و لا منتهية إلى نهاية و هو لازم إطلاق الملك بحسب السياق، و إن كان إطلاق الملك و هو من صفات الفعل من لوازم إطلاق القدرة و هي من صفات الذات.
و في الآية مع ذلك إيماء إلى الحجّة على إمكان ما سيأتي من أمر المعاد.
قوله تعالى: ( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ) الحياة كون الشيء بحيث يشعر و يريد، و الموت عدم ذلك لكنّ الموت على ما يظهر من تعليم القرآن انتقال من نشأة من نشآت الحياة إلى نشأة اُخرى كما تقدّم استفادة ذلك من قوله تعالى:( نَحْنُ قَدَّرْنا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ - إلى قوله -فِي ما لا تَعْلَمُونَ ) الواقعة: 61، فلا مانع من تعلّق الخلق بالموت كالحياة.
على أنّه لو اُخذ عدميّاً كما عند العرف فهو عدم ملكة الحياة و له حظّ من الوجود يصحّح تعلّق الخلق به كالعمى من البصر و الظلمة من النور.
و قوله:( لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ) غاية خلقه تعالى الموت و الحياة، و البلاء الامتحان و المراد أنّ خلقكم هذا النوع من الخلق و هو أنّكم تحيون ثمّ تموتون خلق مقدّميّ امتحانيّ يمتاز به منكم من هو أحسن عملاً من غيره و من المعلوم أنّ الامتحان و التمييز لا يكون إلّا لأمر مّا يستقبلكم بعد ذلك و هو جزاء كلّ بحسب عمله.
و في الكلام مع ذلك إشارة إلى أنّ المقصود بالذات من الخلقة هو إيصال الخير من الجزاء حيث ذكر حسن العمل و امتياز من جاء بأحسنه فالمحسنون عملاً هم المقصودون بالخلقة و غيرهم مقصودون لأجلهم.
و قد ذيّل الكلام بقوله:( وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ) فهو العزيز لأنّ الملك و القدرة المطلقين له وحده فلا يغلبه غالب و ما أقدر أحداً على مخالفته إلّا بلاء و امتحاناً و سينتقم منهم و هو الغفور لأنّه يعفو عن كثير من سيّئاتهم في الدنيا و سيغفر كثيراً منها في الآخرة كما وعد.
و في التذييل بالاسمين مع ذلك تخويف و تطميع على ما يدعو إلى ذلك سياق الدعوة.
و اعلم أنّ مضمون الآية ليس مجرّد دعوى خالية عن الحجّة يراد به التلقين كما ربّما يتوهّم بل هي مقدّمة قريبة من الضرورة - أو هي ضروريّة - تستدعي الحكم
بضرورة البعث للجزاء فإنّ الإنسان المتلبّس بهذه الحياة الدنيويّة الملحوقة للموت لا يخلو من أن يحصل له وصف حسن العمل أو خلافه و هو مجهّز بحسب الفطرة بما لو لا عروض عارض السوء لساقه إلى حسن العمل، و قلّما يخلو إنسان من حصول أحد الوصفين كالأطفال و من في حكمهم.
و الوصف الحاصل المترتّب على وجود الشيء الساري في أغلب أفراده غاية في وجوده مقصودة في إيجاده فكما أنّ الحياة النباتيّة لشجرة كذا إذ كانت تؤدّي في الغالب إلى إثمارها ثمرة كذا يعدّ ذلك غاية لوجودها مقصودة منها كذلك حسن العمل و الصلاح غاية لخلق الإنسان، و من المعلوم أيضاً أنّ الصلاح و حسن العمل لو كان مطلوباً لكان مطلوباً لغيره لا لنفسه، و المطلوب بالذات الحياة الطيّبة الّتي لا يشوبها نقص و لا يعرضها لغو و لا تأثيم فالآية في معنى قوله:( كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً ) الأنبياء: 35.
قوله تعالى: ( الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً ) إلخ، أي مطابقة بعضها فوق بعض أو بعضها يشبه البعض - على ما احتمل - و قد مرّ في تفسير حم السجدة بعض ما يمكننا من القول فيها.
و قوله:( ما تَرى فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ ) قال الراغب: الفوت بعد الشيء عن الإنسان بحيث يتعذّر إدراكه، قال تعالى:( وَ إِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ ) . قال: و التفاوت الاختلاف في الأوصاف كأنّه يفوت وصف أحدهما الآخر أو وصف كلّ واحد منهما الآخر، قال تعالى:( ما تَرى فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ ) أي ليس فيها ما يخرج عن مقتضى الحكمة. انتهى.
فالمراد بنفي التفاوت اتّصال التدبير و ارتباط الأشياء بعضها ببعض من حيث الغايات و المنافع المترتّبة على تفاعل بعضها في بعض، فاصطكاك الأسباب المختلفة في الخلقة و تنازعها كتشاجر كفّتي الميزان و تصارعهما بالثقل و الخفّة و الارتفاع و الانخفاض فإنّهما في عين أنّهما تختلفان تتّفقان في إعانة من بيده الميزان فيما يريده من تشخيص وزن السلعة الموزونة.
فقد رتّب الله أجزاء الخلقة بحيث تؤدّي إلى مقاصدها من غير أن يفوّت بعضها غرض بعض أو يفوت من بعضها الوصف اللازم فيه لحصول الغاية المطلوبة.
و الخطاب في( ما تَرى ) خطاب عامّ لكلّ من يمكنه الرؤية و في إضافة الخلق إلى الرحمن إشارة إلى أنّ الغاية منه هي الرحمة العامّة، و تنكير( تَفاوُتٍ ) و هو في سياق النفي و إدخال( الرَّحْمنِ ) عليه لإفادة العموم.
و قوله:( فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ ) الفطور الاختلال و الوهي، و المراد بإرجاع البصر النظر ثانياً و هو كناية عن المداقّة في النظر و الإمعان فيه.
قوله تعالى: ( ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَ هُوَ حَسِيرٌ ) الخاسئ من خسأ البصر إذا انقبض عن مهانة كما قال الراغب، و قال أيضاً: الخاسر المعيا لانكشاف قواه، و يقال للمعيا: حاسر و محسور: أمّا الحاسر فتصوّر أنّه بنفسه قد حسر قوّته، و أمّا المحسور فتصوّر أن التعب قد حسرة، و قوله عزّوجلّ:( يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَ هُوَ حَسِيرٌ ) يصحّ أن يكون بمعنى حاسر و أن يكون بمعنى محسور. انتهى.
و قوله:( كَرَّتَيْنِ ) الكرّة الرجعة و المراد بالتثنية التكثير و التكرير، و المعنى: ثمّ ارجع البصر رجعة بعد رجعة أي رجعات كثيرة ينقلب إليك البصر منقبضة مهينة و الحال أنّه كليل مُعيا لم يجد فطوراً.
فقد اُشير في الآيتين إلى أنّ النظام الجاري في الكون نظام واحد متّصل الأجزاء مرتبط الأبعاض.
قوله تعالى: ( وَ لَقَدْ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ ) إلى آخر الآية، المصابيح جمع مصباح و هو السراج سمّي الكواكب مصابيح لإنارتها و إضاءتها و قد تقدّم كلام في ذلك في تفسير سورة حم السجدة.
و قوله:( وَ جَعَلْناها رُجُوماً لِلشَّياطِينِ ) أي و جعلنا الكواكب الّتي زيّنّا بها السماء رجوماً يرجم بها من استرق السمع من الشياطين كما قال تعالى:( إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ مُبِينٌ ) الحجر: 18، و قال:( إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ
شِهابٌ ثاقِبٌ ) الصافّات: 10.
قيل: إنّ الجملة دليل أنّ المراد بالكواكب المزيّنة بها السماء مجموع الكواكب الأصليّة و الشهب السماويّة فإنّ الكواكب الأصليّة لا تزول عن مستقرّها و الكواكب و النجم يطلقان على الشهب كما يطلقان على الأجرام الأصليّة.
و قيل: تنفصل من الكواكب شهب تكون رجوماً للشياطين أمّا الكواكب أنفسها فليست تزول إلّا أن يريد الله إفناءها.
و هذا الوجه أوفق للأنظار العلميّة الحاضرة، و قد تقدّم بعض الكلام في معنى رمي الشياطين بالشهب.
و قوله:( وَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذابَ السَّعِيرِ ) أي و هيّأنا للشياطين و هم أشرار الجنّ عذاب النار المسعّرة المشتعلة.
قوله تعالى: ( وَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ ) لمّا أورد بعض آيات ربوبيّته تعالى عقّبها بالوعيد على من كفر بربوبيّته على ما هو شأن هذه السورة من تداخل الحجج و الوعيد و الإنذار.
و المراد بالّذين كفروا بربوبيّته أعمّ من الوثنيّين النافين لربوبيّته لغير أربابهم القائلين بأنّه تعالى ربّ الأرباب فقط، و النافين لها مطلقاً و المثبتين لربوبيّته مع التفريق بينه و بين رسله كاليهود و النصارى حيث آمنوا ببعض رسله و كفروا ببعض.
و الآية مع ذلك متّصلة بقوله:( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ) لما فيها من الإشارة إلى البعث و الجزاء متّصلة بما قبلها كالتعميم بعد التخصيص.
قوله تعالى: ( إِذا أُلْقُوا فِيها سَمِعُوا لَها شَهِيقاً وَ هِيَ تَفُورُ تَكادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ) قال الراغب: الشهيق طول الزفير و هو ردّ النفس و الزفير مدّة انتهى، و الفوران كما في المجمع، ارتفاع الغليان، و التميّز: التقطّع و التفرّق، و الغيظ: شدّة الغضب، و المعنى: إذا طرح الكفّار في جهنّم سمعوا لها شهيقا - أي تجذبهم إلى داخلها كما يجذب الهواء
بالشهيق إلى داخل الصدر - و هي تغلي بهم فترفعهم و تخفضهم تكاد تتلاشى من شدّة الغضب.
قوله تعالى: ( كُلَّما أُلْقِيَ فِيها فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها أَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ) الفوج - كما قاله الراغب - الجماعة المارّة المسرعة، و في قوله:( كُلَّما أُلْقِيَ فِيها فَوْجٌ ) إشارة إلى أنّ الكفّار يلقون في النار جماعة جماعة كما يشير إليه قوله:( وَ سِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ زُمَراً ) الزمر: 71، و إنّما يلقون كذلك بلحوق التابعين لمتبوعيهم في الضلال كما قال تعالى:( وَ يَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ) الأنفال: 37، و قد تقدّم بعض توضيحه في ذيل الآية من سورة الأنفال.
و الخزنة جمع خازن و هو الحافظ على الشيء المدّخر و المراد بهم الملائكة الموكّلون على النار المدبّرون لأنواع عذابها قال تعالى:( عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ ) التحريم: 6، و قال:( وَ ما أَدْراكَ ما سَقَرُ - إلى أن قال -عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ وَ ما جَعَلْنا أَصْحابَ النَّارِ إِلَّا مَلائِكَةً ) المدّثّر: 31.
و المعنى: كلّما طرح في جهنّم جماعة من جماعات الكفّار المسوقين إليها سألهم الملائكة الموكّلون على النار الحافظون لها - توبيخاً - أ لم يأتكم نذير؟ و هو النبيّ المنذر.
قوله تعالى: ( قالُوا بَلى قَدْ جاءَنا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنا ) إلى آخر الآية حكاية جوابهم لسؤال الخزنة، و فيه تصديق أنّهم قد جاءهم نذير فنسبوه إلى الكذب و اعتراف.
و قوله:( ما نَزَّلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ ) بيان لتكذيبهم، و كذا قوله:( إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلالٍ كَبِيرٍ ) و قيل: قوله:( إِنْ أَنْتُمْ ) إلخ، كلام الملائكة يخاطبون به الكفّار بعد جوابهم عن سؤالهم بما أجابوا، و هو بعيد من السياق، و كذا احتمال كونه من كلام الرسل الّذين كذّبوهم تحكيه الملائكة لاُولئك الكفّار.
قوله تعالى: ( وَ قالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَّا فِي أَصْحابِ السَّعِيرِ ) يطلق السمع و يراد به إدراك الصوت و القول بالجارحة و ربّما يراد به ما هو الغاية منه عند العقلاء و هو الالتزام بمقتضاه من الفعل و الترك، و يطلق العقل على تمييز الخير من الشرّ
و النافع من الضارّ، و ربّما يراد به ما هو الغاية منه و هو الالتزام بمقتضاه من طلب الخير و النفع و اجتناب الشرّ و الضرّ، قال تعالى:( لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ) الأعراف: 179.
و أكثر ما ينتفع بالسمع عامّة الناس لقصورهم عن تعقّل دقائق الاُمور و إدراك حقيقتها و الاهتداء إلى مصالحها و مفاسدها و إنّما ينتفع بالعقل الخاصّة.
فقوله:( لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ) اُريد بالسمع استجابة دعوة الرسل و الالتزام بمقتضى قولهم و هم النصحاء الاُمناء، و بالعقل الالتزام بمقتضى ما يدعون إليه من الحقّ بتعقّله و الاهتداء العقليّ إلى أنّه حقّ و من الواجب أن يخضع الإنسان للحقّ.
و إنّما قدّم السمع على العقل لأنّ استعماله من شأن عامّة الناس و هم الأكثرون و العقل شأن الخاصّة و هم آحاد قليلون.
و المعنى: لو كنّا في الدنيا نطيع الرسل في نصائحهم و مواعظهم أو عقلنا حجّة الحقّ ما كنّا اليوم في أصحاب السعير و هم مصاحبو النار المخلّدون فيها.
و قيل: إنّما جمع بين السمع و العقل لأنّ مدار التكليف على أدلّة السمع و العقل.
قوله تعالى: ( فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحابِ السَّعِيرِ ) كانوا إنّما قالوا:( لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَّا فِي أَصْحابِ السَّعِيرِ ) ندامة على ما فرّطوا في جنب الله و فوّتوا على أنفسهم من الخير فاعترفوا بأنّ ما أتوا به كان تبعته دخول النار و كان عليهم أن لا يأتوا به، و هذا هو الذنب فقد اعترفوا بذنبهم.
و إنّما أفرد الذنب بناء على إرادة معنى المصدر منه و هو في الأصل مصدر.
و قوله:( فَسُحْقاً لِأَصْحابِ السَّعِيرِ ) السحق تفتيت الشيء كما ذكره الراغب و هو دعاء عليهم.
قوله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبِيرٌ ) لمّا ذكر حال الكفّار و ما يجازون به على كفرهم قابلة بحال المؤمنين بالغيب لتمام التقسيم و ذكر من وصفهم الخشية لأنّ المقام مقام الإنذار و الوعيد.
و عدّ خشيتهم خشية بالغيب لكون ما آمنوا به محجوباً عنهم تحت حجب الغيب.
قوله تعالى: ( وَ أَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ ) رفع شبهة يمكن أن تختلج في قلوبهم مبنيّة على الاستبعاد و ذلك أنّه تعالى ساق الكلام في بيان ربوبيّته لكلّ شيء المستتبعة للبعث و الجزاء و ذكر ملكه و قدرته المطلقين و خلقه و تدبيره و لم يذكر علمه المحيط بهم و بأحوالهم و أعمالهم و هو ممّا لا يتمّ البعث و الجزاء بدونه.
و كان من الممكن أن يتوهّموا أنّ الأعمال على كثرتها الخارجة عن الإحصاء لا يتأتّى ضبطها و خاصّة ما تكنّه الصدور منها فإنّ الإنسان يقيس الأشياء بنفسه و يزنها بزنة نفسه و هو غير قادر على إحصاء جزئيّات الأعمال الّتي هي حركات مختلفة متقضيّة و خاصّة أعمال القلوب المستكنّة في زواياها.
فدفعه بأنّ إظهار القول و إخفاءه سواء بالنسبة إليه تعالى فإنّه عليم بذات الصدور، و السياق يشهد أنّ المراد استواء خفايا الأعمال و جلاياها بالنسبة إليه، و إنّما ذكر أسرار القول و جهره من حيث ظهور معنى الخفاء و الظهور فيه بالجهر و الإسرار.
قوله تعالى: ( أَ لا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ) استفهام إنكاريّ مأخوذ حجّة على علمه تعالى بأعمال الخلق ظاهرها و باطنها و سرّها و جهرها و ذلك أنّ أعمال الخلق - و من جملتها أعمال الإنسان الاختياريّة - و إن نسبت إلى فواعلها لكنّ الله سبحانه هو الّذي يريدها و يوجدها من طريق اختيار الإنسان و اقتضاء سائر الأسباب فهو الخالق لأعيان الأشياء و المقدّر لها آثارها كيفما كانت و الرابط بينها و بين آثارها الموصل لها إلى آثارها، قال تعالى:( اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ) الزمر: 62، و قال:( الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدى ) الأعلى: 3، فهو سبحانه محيط بعين من خلقه و أثره و من أثره أعماله الظاهرة و الباطنة و ما أسرّه و ما جهر به و كيف يحيط به و لا يعلمه.
و في الآية إشارة إلى أنّ أحوال الأشياء و أعمالها غير خارجة عن خلقها لأنّه
تعالى استدلّ بعلمه بمن خلق على علمه بخصوصيّات أحواله و أعماله و لو لا كون الأحوال و الأعمال غير خارجة عن وجود موضوعاتها لم يتمّ الاستدلال.
على أنّ الأحوال و الأعمال من مقتضيات موضوعاتها و الّذي ينتسب إليه وجود الشيء ينتسب إليه آثار وجوده.
و قوله:( وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ) أي النافذ في بواطن الأشياء المطّلع على جزئيات وجودها و آثارها، و الجملة حالية تعلّل ما قبلها و الاسمان الكريمان من الأسماء الحسنى ذيّلت بهما الآية لتأكيد مضمونها.
( بحث روائي)
في الكافي، بإسناده عن سفيان بن عيينة عن أبي عبداللهعليهالسلام في قول الله عزّوجلّ:( لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ) قال: ليس يعني أكثركم عملاً و لكن أصوبكم عملاً، و إنّما الإصابة خشية الله و النيّة الصادقة و الخشية.
ثمّ قال: الإبقاء على العمل حتّى يخلص أشدّ من العمل.
ألا و العمل الخالص الّذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلّا الله، و النيّة أفضل من العمل ألا و إنّ النيّة هي العمل. ثمّ تلا قوله:( قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ ) يعني على نيّته.
و في المجمع، قال أبو قتادة: سألت النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم عن قوله تعالى:( أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ) ما عنى به؟ فقال: يقول: أيّكم أحسن عقلاً. ثمّ قال: أتمّكم عقلاً و أشدّكم لله خوفاً، و أحسنكم فيما أمر الله به و نهى عنه نظراً و إن كان أقلّكم تطوّعاً.
و فيه، عن ابن عمر عن النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه تلا قوله تعالى:( تَبارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ - إلى قوله -أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ) ثمّ قال: أيّكم أحسن عقلاً، و أورع عن محارم الله و أسرع في طاعة الله.
و في تفسير القمّيّ في قوله تعالى:( الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً ) قال: بعضها طبق لبعض.
و فيه في قوله تعالى:( مِنْ تَفاوُتٍ ) قال: من فساد.
و فيه في قوله تعالى:( ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ ) قال: انظر في ملكوت السماوات و الأرض.
و فيه في قوله تعالى:( بِمَصابِيحَ ) قال: بالنجوم.
و فيه في قوله تعالى:( سَمِعُوا لَها شَهِيقاً ) قال: وقعاً.
و فيه في قوله تعالى:( تَكادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ) قال: على أعداء الله.
و فيه في قوله تعالى:( وَ قالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَّا فِي أَصْحابِ السَّعِيرِ ) قال: قد سمعوا و عقلوا و لكنّهم لم يطيعوا و لم يقبلوا، و الدليل على أنّهم قد سمعوا و عقلوا و لم يقبلوا، قوله:( فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحابِ السَّعِيرِ ) .
أقول: يعنيعليهالسلام أنّه يدلّ على أنّ المراد من عدم السمع و العقل عدم الإطاعة و القبول بعد السمع و العقل أنّه تعالى سمّى قولهم ذلك اعترافاً بالذنب، و لا يعدّ فعل ذنباً من فاعله إلّا بعد العلم بجهة مساءته بسمع أو عقل.
( سورة الملك الآيات 15 - 22)
هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ( 15 ) أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ( 16 ) أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ( 17 ) وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ( 18 ) أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ( 19 ) أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ( 20 ) أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ( 21 ) أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ( 22 )
( بيان)
في الآيات كرّة بعد كرّة بآيات التدبير الدالّة على ربوبيّته تعالى مقرونة بالإنذار و التخويف أعني قوله:( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا ) الآية، و قوله:( أَ وَ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ ) الآية بعد قوله:( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَياةَ ) الآية، و قوله:( الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ ) الآية، و قوله:( وَ لَقَدْ زَيَّنَّا ) الآية.
قوله تعالى: ( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَناكِبِها وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَيْهِ النُّشُورُ ) الذلول من المراكب ما يسهل ركوبه من غير أن يضطرب و يجمح و المناكب جمع منكب و هو مجتمع ما بين العضد و الكتف و أستعير لسطح الأرض، قال
الراغب: و استعارته للأرض كاستعارة الظهر لها في قوله:( ما تَرَكَ عَلى ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ ) و تسمية الأرض ذلولاً و جعل ظهورها مناكب لها يستقرّ عليها و يمشي فيها باعتبار انقيادها لأنواع التصرّفات الإنسانيّة من غير امتناع، و قد وجّه كونها ذلولاً ذا مناكب بوجوه مختلفة تؤل جميعها إلى ما ذكرنا.
و الأمر في قوله:( وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ) للإباحة و النشور و النشر إحياء الميّت بعد موته و أصله من نشر الصحيفة و الثوب إذا بسطهما بعد طيّهما.
و المعنى: هو الّذي جعل الأرض مطاوعة منقادة لكم يمكنكم أن تستقرّوا على ظهورها و تمشوا فيها تأكلون من رزقه الّذي قدّره لكم بأنواع الطلب و التصرّف فيها.
و قوله:( وَ إِلَيْهِ النُّشُورُ ) أي و يرجع إليه نشر الأموات بإخراجهم من الأرض و إحيائهم للحساب و الجزاء، و اختصاص رجوع النشر به كناية عن اختصاص الحكم بالنشور به و الإحياء يوم القيامة فهو ربّكم المدبّر لأمر حياتكم الدنيا بالإقرار على الأرض و الهداية إلى مآرب الحياة، و له الحكم بالنشور للحساب و الجزاء.
و في عدّ الأرض ذلولاً و البشر على مناكبها تلويح ظاهر إلى ما أدّت إليه الأبحاث العلميّة أخيراً من كون الأرض كرّة سيّارة.
قوله تعالى: ( أَ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذا هِيَ تَمُورُ ) إنذار و تخويف بعد إقامة الحجّة و توبيخ على مساهلتهم في أمر الربوبيّة و إهمالهم أمر الشكر على نعم ربّهم بالخضوع لربوبيّته و رفض ما اختلقوه من الأنداد.
و المراد بمن في السماء الملائكة المقيمون فيها الموكّلون على حوادث الكون و إرجاع ضمير الإفراد إلى( مَنْ ) باعتبار لفظه و خسف الأرض بقوم كذا شقّها و تغييبهم في بطنها و المور على ما في المجمع التردّد في الذهاب و المجيء مثل الموج.
و المعنى: ء أمنتم في كفركم بربوبيّته تعالى الملائكة المقيمين في السماء الموكلين باُمور العالم أن يشقّوا الأرض و يغيّبوكم فيها بأمر الله فإذا الأرض تضطرب ذهاباً و مجيئاً بزلزالها.
و قيل: المراد بمن في السماء هو الله سبحانه و المراد بكونه في السماء كون سلطانه و تدبيره و أمره فيها لاستحالة أن يكون تعالى في مكان أو جهة أو محاطاً بعالم من العوالم، و هذا المعنى و إن كان لا بأس به لكنّه خلاف الظاهر.
قوله تعالى: ( أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ) الحاصب الريح الّتي تأتي بالحصاة و الحجارة، و المعنى: أ أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم ريحاً ذات حصاة و حجارة كما أرسلها على قوم لوط قال تعالى:( إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ حاصِباً إِلَّا آلَ لُوطٍ ) القمر: 34.
و قوله:( فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ) النذير مصدر بمعنى الإنذار و الجملة متفرّعة على ما يفهم من سابق الكلام من كفرهم بربوبيّته تعالى و أمنهم من عذابه و المعنى ظاهر.
و قيل: النذير صفة بمعنى المنذر و المراد به النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم و هو سخيف.
قوله تعالى: ( وَ لَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ ) المراد بالنكير العقوبة و تغيير النعمة أو الإنكار، و الآية كالشاهد يستشهد به على صدق ما في قوله:( فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ) من الوعيد و التهديد.
و المعنى: و لقد كذّب الّذين من قبلهم من الاُمم الهالكة رسلي و جحدوا بربوبيّتي فكيف كان عقوبتي و تغييري النعمة عليهم أو كيف كان إنكاري ذلك عليهم حيث أهلكتهم و استأصلتهم.
و في الآية التفات من الخطاب إلى الغيبة في قوله:( مِنْ قَبْلِهِمْ ) إشعاراً بسقوطهم - لجهالتهم و إهمالهم في التدبّر في آيات الربوبيّة و عدم مخافتهم من سخط ربّهم - عن تشريف الخطاب فأعرض عن مخاطبتهم فيما يلقى إليهم من المعارف إلى خطاب النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم .
قوله تعالى: ( أَ وَ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صافَّاتٍ وَ يَقْبِضْنَ ما يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ) المراد بكون الطير فوقهم طيرانه في الهواء، و صفيف الطير بسطه جناحه حال الطيران و قبضه قبض جناحه حاله، و الجمع في( صافَّاتٍ وَ يَقْبِضْنَ ) لكون المراد بالطير استغراق الجنس.
و قوله:( ما يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمنُ ) كالجواب لسؤال مقدّر كأنّ سائلاً يسأل فيقول: ما هو المراد بإلفات نظرهم إلى صفيف الطير و قبضه فوقهم؟ فاُجيب بقوله:( ما يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمنُ ) .
و قرار الطير حال الطيران في الهواء من غير سقوط و إن كان مستنداً إلى أسباب طبيعيّة كقرار الإنسان على بسيط الأرض و السمك في الماء و سائر الاُمور الطبيعيّة المستندة إلى علل طبيعيّة تنتهي إليه تعالى لكن لمّا كان بعض الحوادث غير ظاهر السبب للإنسان في بادي النظر سهل له إذا نظر إليه أن ينتقل إلى أنّ الله سبحانه هو السبب الأعلى الّذي ينتهي إليه حدوثه و وجوده، و لذا نبهّهم الله سبحانه في كلامه بإرجاع نظرهم إليها و دلالتهم على وحدانيّته في الربوبيّة.
و قد ورد في كلامه تعالى شيء كثير من هذا القبيل كإمساك السماوات بغير عمد و إمساك الأرض و حفظ السفن على الماء و اختلاف الأثمار و الألوان و الألسنة و غيرها ممّا كان سببه الطبيعيّ القريب خفيّاً في الجملة يسهل للذهن الساذج الانتقال إلى استناده إليه تعالى ثمّ إذا تنبّه لوجود أسبابه القريبة بنوع من المجاهدة الفكرية وجد الحاجة بعينها في أسبابه حتّى تنتهي إليه تعالى و أنّ إلى ربّك المنتهى.
قال في الكشّاف: فإن قلت: لم قيل: و يقبضن و لم يقل: و قابضات؟ قلت: لأنّ الأصل في الطيران هو صفّ الأجنحة لأنّ الطيران في الهواء كالسباحة في الماء و الأصل في السباحة هو مدّ الأطراف و بسطها و أمّا القبض فطارئ على البسط للاستظهار به على التحرّك فجيء بما هو طار غير أصل بلفظ الفعل على معنى أنّهنّ صافّات و يكون منهنّ القبض تارة كما يكون من السابح. انتهى.
و هو مبنيّ على أن تكون الآية هي مجموع قوله:( صافَّاتٍ وَ يَقْبِضْنَ ) و هو الطيران، و يمكن أن يستفاد أنّ الآية عدم سقوطهنّ و هن صافّات، و آية اُخرى أنّهنّ ربّما يقبضن و لا يسقطن حينما يقبضن.
و لا يخفى ما في ذكر طيران الطير في الهواء بعد ذكر جعل الأرض ذلولاً و الإنسان على مناكبها من اللطف.
قوله تعالى: ( أَمَّنْ هذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ إِنِ الْكافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ) توبيخ و تقريع لهم في اتّخاذهم آلهة من دون الله لينصروهم و لذا التفت عن الغيبة إلى الخطاب فخاطبهم ليشتدّ عليهم التقريع.
و قوله:( أَمَّنْ هذَا الَّذِي ) إلخ، معناه بل من الّذي يشار إليه فيقال: هذا جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن أرادكم بسوء أو عذاب؟ فليس دون الله من ينصركم عليه، و فيه إشارة إلى خطإهم في اتّخاذ بعض خلق الله آلهة لينصروهم في النوائب و هم مملوكون لله لا يملكون لأنفسهم نفعاً و ضرّاً و لا لغيرهم.
و إذ لم يكن لهم جواب أجاب تعالى بقوله:( إِنِ الْكافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ) أي أحاط بهم الغرور و غشيهم فخيّل إليهم ما يدّعون من اُلوهيّة آلهتهم.
قوله تعالى: ( أَمَّنْ هذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَ نُفُورٍ ) أي بل من الّذي يشار إليه بأنّ هذا هو الّذي يرزقكم إن أمسك الله رزقه فينوب مقامه فيرزقكم؟ ثمّ أجاب سبحانه بقوله:( بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَ نُفُورٍ ) أي إنّ الحقّ قد تبيّن لهم لكنّهم لا يخضعون للحقّ بتصديقه ثمّ اتّباعه بل تمادوا في ابتعادهم من الحقّ و نفورهم منه، و لجّوا في ذلك.
قوله تعالى: ( أَ فَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلى وَجْهِهِ أَهْدى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ) إكباب الشيء على وجهه إسقاطه عليه، و قال في الكشّاف: معنى أكبّ دخل في الكبّ و صار ذا كبّ.
استفهام إنكاري عن استواء الحالين تعريضاً لهم بعد ضرب حجاب الغيبة عليهم و تحريمهم من تشريف الحضور و الخطاب بعد استقرار اللجاج فيهم، و المراد أنّهم بلجاجهم في عتوّ عجيب و نفور من الحقّ كمن يسلك سبيلاً و هو مكبّ على وجه لا يرى ما في الطريق من ارتفاع و انخفاض و مزالق و معاثر فليس هذا السائر كمن يمشي سويّا على صراط مستقيم فيرى موضع قدمه و ما يواجهه من الطريق على استقامة، و ما يقصده من الغاية و هؤلاء الكفّار سائرون سبيل الحياة و هم يعاندون الحقّ على علم به فيغمضون عن معرفة ما عليهم أن يعرفوه و العمل بما عليهم أن يعملوا به و لا
يخضعون للحقّ حتّى يكونوا على بصيرة من الأمر و يسلكوا سبيل الحياة و هم مستوون على صراط مستقيم فيأمنوا الهلاك.
و قد ظهر أنّ ما في الآية مثل عامّ يمثّل حال الكافر الجاهل اللجوج المتمادي على جهله و المؤمن المستبصر الباحث عن الحقّ.
( بحث روائي)
في الكافي، بإسناده عن سعد عن أبي جعفرعليهالسلام قال: القلب أربعة: قلب فيه نفاق و إيمان، و قلب منكوس، و قلب مطبوع، و قلب أزهر. فقلت: ما الأزهر، قال: فيه كهيئة السراج.
فأمّا المطبوع فقلب المنافق، و أمّا الأزهر فقلب المؤمن إن أعطاه شكر و إن ابتلاه صبر، و أمّا المنكوس فقلب المشرك ثمّ قرأ هذه الآية( أَ فَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلى وَجْهِهِ أَهْدى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ) ، فأمّا القلب الّذي فيه إيمان و نفاق فقوم كانوا بالطائف فإن أدرك أحدهم أجله على نفاقه هلك و إن أدركه على إيمانه نجى.
أقول: و رواه في تفسير البرهان، عن ابن بابويه بإسناده عن الفضيل عن سعد الخفّاف عن أبي جعفرعليهالسلام قال: إنّ القلوب أربعة، و ساق الحديث إلى آخره إلّا أنّ فيه: و قلب أزهر أنور.
و قوله:( فهم قوم كانوا بالطائف) المراد به الطائف الشيطانيّ الّذي ربّما يمسّ الإنسان قال تعالى:( إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ ) الأعراف: 201، فالمعنى أنّهم يعيشون مع طائف شيطانيّ يمسّهم حيناً بعد حين فإن أدركهم الأجل و الطائف معهم هلكوا و إن أدركهم و هم في حال الإيمان نجوا.
و اعلم أنّ هناك روايات تطبّق قوله:( أَ فَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلى وَجْهِهِ ) الآية على من حاد عن ولاية عليّعليهالسلام و من يتّبعه و يواليه، و هي من الجري و الله أعلم.
( سورة الملك الآيات 23 - 30)
قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ( 23 ) قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ( 24 ) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ( 25 ) قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ( 26 ) فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ ( 27 ) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ( 28 ) قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ( 29 ) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ ( 30 )
( بيان)
آيات اُخر يذكّرهم الله تعالى بها دالّة على وحدانيّته تعالى في الخلق و التدبير مقرونة بالإنذار و التخويف، جارية على غرض السورة و هو التذكرة بالوحدانيّة مع الإنذار غير أنّه تعالى لما أشار إلى لجاجهم و عنادهم للحقّ في قوله السابق:( بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَ نُفُورٍ ) غير السياق بالإعراض عن خطابهم و الالتفات إلى خطاب النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم بأمره أن يتصدّى خطابهم و يقرع أسماعهم آياته في الخلق و التدبير الدالّة على توحّده في الربوبيّة و إنذارهم بعذاب الله، و ذلك قوله:( قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ ) إلخ،
( قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ ) إلخ،( قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ ) إلخ،( قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللهُ ) إلخ،( قُلْ هُوَ الرَّحْمنُ ) إلخ،( قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً ) إلخ.
قوله تعالى: ( قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا ما تَشْكُرُونَ ) الإنشاء إحداث الشيء ابتداء و تربّيه.
ما في ذيل الآية من لحن العتاب في قوله:( قَلِيلًا ما تَشْكُرُونَ ) و قد تكرّر نظيره في غير موضع من كلامه كما في سورة المؤمنون(1) و الم السجدة(2) يدلّ على أنّ إنشاءه تعالى الإنسان و تجهيزه بجهاز الحسّ و الفكر من أعظم نعمه تعالى الّتي لا يقدّر قدرها.
و ليس المراد بإنشائه مجرّد خلقه كيفما كان بل خلقه و إحداثه من دون سابقه في مادّته كما أشار إليه في قوله يصف خلقه طوراً بعد طور:( وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً - إلى أن قال -ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ ) المؤمنون: 14، فصيرورة المضغة إنساناً سميعاً بصيراً متفكّراً بتركيب النفس الإنسانيّة عليها خلق آخر لا يسانخ أنواع الخلقة المادّيّة الواردة على مادّة الإنسان من أخذها من الأرض ثمّ جعلها نطفة ثمّ علقة ثمّ مضغة فإنّما هي أطوار مادّيّة متعاقبة بخلاف صيرورتها إنساناً ذا شعور فلا سابقة لها تماثلها أو تشابهها فهو الإنشاء.
و مثله قوله:( وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ إِذا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ) الروم: 20 (انظر إلى موضع إذا الفجائيّة).
فقوله:( هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ ) إشارة إلى خلق الإنسان.
و قوله:( وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ ) إشارة إلى تجهيزه بجهاز الحسّ و الفكر، و الجعل إنشائيّ كجعل نفس الإنسان كما يشير إليه قوله:( وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا ما تَشْكُرُونَ ) المؤمنون: 78.
____________________
(1) الآية 78.
(2) الآية 9
فالإنسان بخصوصيّة إنشائه و كونه بحيث يسمع و يبصر يمتاز من الجماد و النبات - و الاقتصار بالسمع و البصر من سائر الحواسّ كاللمس و الذوق و الشمّ لكونهما العمدة و لا يبعد أن يكون المراد بالسمع و البصر مطلق الحواسّ الظاهرة من باب إطلاق الجزء و إرادة الكلّ - و بالفؤاد و هو النفس المتفكّرة يمتاز من سائر الحيوان.
و قوله:( قَلِيلًا ما تَشْكُرُونَ ) أي تشكرون قليلاً على هذه النعمة - أو النعم - العظمى فما زائدة و قليلاً مفعول مطلق تقديره تشكرون شكراً قليلاً، و قيل: ما مصدريّة و المعنى: قليلا شكركم.
قوله تعالى: ( قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ) الذرء الخلق و المراد بذرئهم في الأرض خلقهم متعلّقين بالأرض فلا يتمّ لهم كمالهم إلّا بأعمال متعلّقة بالمادّة الأرضيّة بما زيّنها الله تعالى بما تنجذب إليه النفس الإنسانيّة في حياتها المعجّلة ليمتاز به الصالح من الطالح قال تعالى:( إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَ إِنَّا لَجاعِلُونَ ما عَلَيْها صَعِيداً جُرُزاً ) الكهف: 8.
و قوله:( وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ) إشارة إلى البعث و الجزاء و وعد جازم.
قوله تعالى: ( وَ يَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ) المراد بهذا الوعد الحشر الموعود، و هو استعجال منهم استهزاء.
قوله تعالى: ( قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ وَ إِنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ) جواب عن قولهم:( مَتى هذَا الْوَعْدُ ) إلخ، و محصّله أنّ العلم به عندالله لا يعلم به إلّا هو كما قال:( لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ ) الأعراف: 187، و ليس لي إلّا أنّي نذير مبين اُمرت أن اُخبركم أنّكم إليه تحشرون و أمّا أنّه متى هو فليس لي بذلك علم.
هذا على ما يفيده وقوع الآية في سياق الجواب عن السؤال عن وقت الحشر، و على هذا تكون اللام في العلم للعهد، و المراد العلم بوقت الحشر، و أمّا لو كانت للجنس على ما تفيده جملة( إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ ) في نفسها فالمعنى: إنّما حقيقة العلم عندالله و لا يحاط بشيء منه إلّا بإذنه كما قال:( وَ لا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما
شاءَ ) البقرة: 255، و لم يشأ أن أعلم من ذلك إلّا أنّه سيقع و اُنذركم به و أمّا أنّه متى يقع فلا علم لي به.
قوله تعالى: ( فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) إلخ، الزلفة القرب و المراد به القريب أو هو من باب زيد عدل، و ضمير( رَأَوْهُ ) للوعد و قيل للعذاب و المعنى: فلمّا رأوا الوعد المذكور قريباً قد أشرف عليهم ساء ذلك وجوه الّذين كفروا به فظهر في سيماهم أثر الخيبة و الخسران.
و قوله:( وَ قِيلَ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ) قيل تدعون و تدّعون بمعنى واحد كتدخرون و تدّخرون و المعنى: و قيل لهم: هذا هو الوعد الّذي كنتم تسألونه و تستعجلون به بقولكم: متى هذا الوعد، و ظاهر السياق أنّ القائل هم الملائكة بأمر من الله، و قيل القائل من الكفّار يقوله بعضهم لبعض.
قوله تعالى: ( قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللهُ وَ مَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنا فَمَنْ يُجِيرُ الْكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ ) ( إِنْ ) شرطيّة شرطها قوله:( أَهْلَكَنِيَ اللهُ ) و جزاؤها قوله:( فَمَنْ يُجِيرُ ) إلخ، و المعنى: قل لهم أخبروني إن أهلكني الله و من معي من المؤمنين أو رحمنا فلم يهلكنا فمن الّذي يجير و يعيد الكافرين - و هم أنتم كفرتم بالله فاستحققتم أليم العذاب - من عذاب أليم يهدّدهم تهديداً قاطعاً أي إنّ هلاكي و من معي و بقاؤنا برحمة ربّي لا ينفعكم شيئاً في العذاب الّذي سيصيبكم قطعاً بكفركم بالله.
قيل: إنّ كفّار مكّة كانوا يدعون على رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم و على المؤمنين بالهلاك فأمرصلىاللهعليهوآلهوسلم أن يقول لهم إن أهلكنا الله تعالى أو أبقانا فأمرنا إلى الله و نرجو الخير من رحمته و أمّا أنتم فما تصنعون؟ من يجيركم من أليم العذاب على كفركم بالله.؟
قوله تعالى: ( قُلْ هُوَ الرَّحْمنُ آمَنَّا بِهِ وَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ ) الضمير للّذي يدعو إلى توحيده و هم يدعونه عليه، و المعنى: قل الّذي أدعوكم إلى توحيده و تدعونه عليّ و على من معي هو الرحمن الّذي عمّت نعمته كلّ شيء آمنّا به و عليه توكّلنا من غير أن نميل و نعتمد على شيء دونه فستعلمون أيّها الكفّار من هو في ضلال مبين؟ نحن أم أنتم.؟
قال في الكشّاف: فإن قيل: لم اُخّر مفعول( آمَنَّا ) و قدّم مفعول( تَوَكَّلْنا ) ؟ قلت: لوقوع آمنّا تعريضاً بالكافرين حين ورد عقيب ذكرهم كأنّه قيل: آمنّا و لم نكفر كما كفرتم، ثمّ قال: و عليه توكّلنا خصوصاً لم نتّكل على ما أنتم متّكلون عليه من رجالكم و أموالكم.
قوله تعالى: ( قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِماءٍ مَعِينٍ ) الغور ذهاب الماء و نضوبه في الأرض و المراد به الغائر، و المعين الظاهر الجاري من الماء، و المعنى: أخبروني إن صار ماؤكم غائراً ناضباً في الأرض فمن يأتيكم بماء ظاهر جار.
و هناك روايات تطبّق الآيات على ولاية عليّعليهالسلام و محادّته، و هي من الجري و ليست بمفسّرة.
( سورة القلم مكّيّة و هي اثنتان و خمسون آية)
( سورة القلم الآيات 1 - 33)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ( 1 ) مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ( 2 ) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ( 3 ) وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ( 4 ) فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ( 5 ) بِأَييِّكُمُ الْمَفْتُونُ ( 6 ) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ( 7 ) فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ( 8 ) وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ( 9 ) وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ( 10 ) هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ( 11 ) مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ( 12 ) عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ ( 13 ) أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ( 14 ) إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ( 15 ) سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ( 16 ) إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ( 17 ) وَلَا يَسْتَثْنُونَ ( 18 ) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ( 19 ) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ( 20 ) فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ( 21 ) أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ( 22 ) فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ( 23 ) أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ( 24 ) وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ ( 25 ) فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ( 26 ) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ( 27 ) قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ( 28 ) قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ( 29 ) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
يَتَلَاوَمُونَ ( 30 ) قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ( 31 ) عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ( 32 ) كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ( 33 )
( بيان)
السورة تعزّى النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم إثر ما رماه المشركون بالجنون و تطيّب نفسه بالوعد الجميل و الشكر على خلقه العظيم و تنهاه نهياً بالغاً عن طاعتهم و مداهنتهم، و تأمره أمراً أكيداً بالصبر لحكم ربّه.
و سياق آياتها على الجملة سياق مكّيّ، و نقل عن ابن عباس و قتادة أنّ صدرها إلى قوله:( سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ) - ستّة عشرة آية - مكّيّ، و ما بعده إلى قوله:( لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ ) - سبع عشرة آية - مدنيّ، و ما بعده إلى قوله:( يَكْتُبُونَ ) - خمس عشرة آية - مكّيّ، و ما بعده إلى آخر السورة - أربع آيات - مدنيّ.
و لا يخلو من وجه بالنسبة إلى الآيات السبع عشرة( إِنَّا بَلَوْناهُمْ - إلى قوله -لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ ) فإنّها أشبه بالمدنيّة منها بالمكّيّة.
قوله تعالى: ( ن ) تقدّم الكلام في الحروف المقطّعة الّتي في أوائل السور في تفسير سورة الشورى.
قوله تعالى: ( وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ ) القلم معروف، و السطر بالفتح فالسكون و ربّما يستعمل بفتحتين - كما في المفردات - الصفّ من الكتابة، و من الشجر المغروس و من القوم الوقوف و سطر فلان كذا كتب سطراً سطراً.
أقسم سبحانه بالقلم و ما يسطرون به و ظاهر السياق أنّ المراد بذلك مطلق القلم و مطلق ما يسطرون به و هو المكتوب فإنّ القلم و ما يسطر به من الكتابة من أعظم النعم الإلهيّة الّتي اهتدى إليها الإنسان يتلو الكلام في ضبط الحوادث الغائبة عن الأنظار
و المعاني المستكنّة في الضمائر، و به يتيسّر للإنسان أن يستحضر كلّ ما ضرب مرور الزمان أو بعد المكان دونه حجاباً.
و قد امتنّ الله سبحانه على الإنسان بهدايته إليهما و تعليمهما له فقال في الكلام( خَلَقَ الْإِنْسانَ عَلَّمَهُ الْبَيانَ ) الرحمن: 4 و قال في القلم:( عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ ) العلق: 5.
فإقسامه تعالى بالقلم و ما يسطرون إقسام بالنعمة، و قد أقسم تعالى في كلامه بكثير من خلقه بما أنّه رحمة و نعمة كالسماء و الأرض و الشمس و القمر و الليل و النهار إلى غير ذلك حتّى التين و الزيتون.
و قيل:( ما ) في قوله:( وَ ما يَسْطُرُونَ ) مصدريّة و المراد به الكتابة.
و قيل: المراد بالقلم القلم الأعلى الّذي في الحديث أنّه أوّل ما خلق الله و بما يسطرون ما يسطره الحفظة و الكرام الكاتبون و احتمل أيضاً أن يكون الجمع في( يَسْطُرُونَ ) للتعظيم لا للتكثير و هو كما ترى، و احتمل أن يكون المراد ما يسطرون فيه و هو اللوح المحفوظ و احتمل أن يكون المراد بالقلم و ما يسطرون أصحاب القلم و مسطوراتهم و هي احتمالات واهية.
قوله تعالى: ( ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ) مقسم عليه و الخطاب للنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم ، و الباء في( بِنِعْمَةِ ) للسببية أو المصاحبة أي ما أنت بمجنون بسبب النعمة - أو مع النعمة - الّتي أنعمها عليك ربّك.
و السياق يؤيّد أنّ المراد بهذه النعمة النبوّة فإنّ دليل النبوّة يدفع عن النبيّ كلّ اختلال عقليّ حتّى تستقيم الهداية الإلهيّة اللّازمة في نظام الحياة الإنسانيّة، و الآية تردّ ما رموه به من الجنون كما يحكي عنهم في آخر السورة( وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ) .
و قيل: المراد بالنعمة فصاحتهصلىاللهعليهوآلهوسلم و عقله الكامل و سيرته المرضيّة و براءته من كلّ عيب و اتّصافه بكلّ مكرمة فظهور هذه الصفات فيهصلىاللهعليهوآلهوسلم ينافي حصول الجنون فيه و ما قدّمناه أقطع حجّة و الآية و ما يتلوها كما ترى تعزية للنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم و تطييب
لنفسه الشريفة و تأييد له كما أنّ فيها تكذيباً لقولهم.
قوله تعالى: ( وَ إِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ ) الممنون من المنّ بمعنى القطع يقال: منّه لسير منّاً إذا قطعه و أضعفه لا من المنّة بمعنى تثقيل النعمة قولاً.
و المراد بالأجر أجر الرسالة عندالله سبحانه، و فيه تطييب لنفس النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم و أنّ له على تحمّل رسالة الله أجراً غير مقطوع و ليس يذهب سدىً.
و ربّما اُخذ المنّ بمعنى ذكر المنعم إنعامه على المنعم عليه بحيث يثقل عليه و يكدّر عيشه بتقريب أنّ ما يعطيه الله أجر في مقابل عمله فهو يستحقّه عليه تعالى فلا منّه عليه و هو غير سديد فإنّ كلّ عامل مملوك لله سبحانه بحقيقة معنى الملك بذاته و صفاته و أعماله فما يعطيّه العبد من ذلك فهو موهبة و عطيّة و ما يملكه العبد من ذلك فإنّما يملكه بتمليك الله و هو المالك لما ملّكه من قبل و من بعد فهو تفضّل منه تعالى و لئن سمّى ما يعطيه بإزاء العمل أجراً و سمّى ما بينه و بين عبده من مبادلة العمل و الأجر معاملة فذلك تفضّل آخر فللّه سبحانه المنّة على جميع خلقه و الرسول و من دونه فيه سواء.
قوله تعالى: ( وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) الخلق هو الملكة النفسانيّة الّتي تصدر عنها الأفعال بسهولة و ينقسم إلى الفضيلة و هي الممدوحة كالعفّة و الشجاعة، و الرذيلة و هي المذمومة كالشره و الجبن لكنه إذا اُطلق فهم منه الخلق الحسن.
قال الراغب: و الخلق - بفتح الخاء - و الخلق - بضمّ الخاء - في الأصل واحد كالشَرب و الشُرب و الصرم و الصُرم لكن خصّ الخلق - بالفتح - بالهيئات و الأشكال و الصور المدركة بالبصر، و خصّ الخلق - بالضمّ - بالقوى و السجايا المدركة بالبصيرة قال تعالى:( وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) انتهى.
و الآية و إن كانت في نفسها تمدح حسن خلقهصلىاللهعليهوآلهوسلم و تعظّمه غير أنّها بالنظر إلى خصوص السياق ناظرة إلى أخلاقه الجميلة الاجتماعيّة المتعلّقة بالمعاشرة كالثبات على الحقّ و الصبر على أذى الناس و جفاء أجلافهم و العفو و الإغماض و سعة البذل و الرفق و المداراة و التواضع و غير ذلك، و قد أوردنا في آخر الجزء السادس من الكتاب
ما روي في جوامع أخلاقهصلىاللهعليهوآلهوسلم .
و ممّا تقدّم يظهر أنّ ما قيل: إنّ المراد بالخلق الدين و هو الإسلام غير مستقيم إلّا بالرجوع إلى ما تقدّم.
قوله تعالى: ( فَسَتُبْصِرُ وَ يُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ ) تقريع على محصّل ما تقدّم أي فإذا لم تكن مجنوناً بل متلبّساً بالنبوّة و متخلّقاً بالخلق و لك عظيم الأجر من ربّك فسيظهر أمر دعوتك و ينكشف على الأبصار و البصائر من المفتون بالجنون؟ أنت أو المكذّبون الرامون لك بالجنون.
و قيل: المراد ظهور عاقبة أمر الدعوة له و لهم في الدنيا أو في الآخرة؟ الآية تقبل الحمل على كلّ منها. و لكلّ قائل، و لا مانع من الجمع فإنّ الله تعالى أظهر نبيّه عليهم و دينه على دينهم، و رفع ذكرهصلىاللهعليهوآلهوسلم و محا أثرهم في الدنيا و سيذوقون وبال أمرهم غداً و يعلمون(1) أنّ الله هو الحقّ المبين يوم هم(2) على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الّذي كنتم به تستعجلون.
و قوله:( بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ ) الباء زائدة للصلة، و المفتون اسم مفعول من الفتنة بمعنى الابتلاء يريد به المبتلى بالجنون و فقدان العقل، و المعنى: فستبصر و يبصرون أيّكم المفتون المبتلى بالجنون؟ أنت أم هم.؟
و قيل: المفتون مصدر على زنة مفعول كمعقول و ميسور و معسور في قولهم: ليس له معقول، و خذ ميسوره، و دع معسوره، و الباء في( بِأَيِّكُمُ ) بمعنى في و المعنى: فستبصر و يبصرون في أي الفريقين الفتنة.
قوله تعالى: ( إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ) لمّا اُفيد بما تقدّم من القول أنّ هناك ضلالاً و اهتداء، و اُشير إلى أنّ الرامين للنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم بالجنون هم المفتونون الضالّون و سيظهر أمرهم و أنّ النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم
____________________
(1) النور: 35.
(2) الذاريات: 14
مهتد و كان ذلك ببيان من الله سبحانه أكّد ذلك بأنّ الله أعلم بمن ضلّ عن سبيله و هو أعلم بالمهتدين لأنّ السبيل سبيله و هو أعلم بمن هو في سبيله و من ليس فيه و إليه أمر الهداية.
قوله تعالى: ( فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ) تفريع على المحصّل من معنى الآيات السابقة و في المكذّبين معنى العهد و المراد بالطاعة مطلق الموافقة عملاً أو قولاً، و المعنى: فإذا كان هؤلاء المكذّبون لك مفتونين ضالّين فلا تطعهم.
قوله تعالى: ( وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ) الإدهان من الدهن يراد به التليين أي ودّ و أحبّ هؤلاء المكذّبون أن تليّنهم بالاقتراب منهم في دينك فيليّنوك بالاقتراب منك في دينهم، و محصّله أنّهم ودّوا أن تصالحهم و يصالحوك على أن يتسامح كلّ منكم بعض المسامحة في دين الآخر كما قيل: إنّهم عرضوا عليه أن يكفّ عن ذكر آلهتهم فيكفّوا عنه و عن ربّه.
و بما تقدّم ظهر أنّ متعلّق مودّتهم مجموع( لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ) و أنّ الفاء في( فَيُدْهِنُونَ ) للتفريع لا للسببيّة.
قوله تعالى: ( وَ لا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ - إلى قوله -زَنِيمٍ ) الحلّاف كثير الحلف، و لازم كثرة الحلف و الإقسام في كلّ يسير و خطير و حقّ و باطل أن لا يحترم الحالف شيئاً ممّا يقسم به، و إذا كان حلفه بالله فهو لا يستشعر عظمة الله عزّ اسمه و كفى به رذيلة.
و المهين من المهانة بمعنى الحقارة و المراد به حقارة الرأي، و قيل: هو المكثار في الشرّ، و قيل: هو الكذّاب.
و الهمّاز مبالغة من الهمز و المراد به العيّاب و الطعّان، و قيل: الطعّان بالعين و الإشارة و قيل: كثير الاغتياب.
و المشّاء بنميم النميم: السعاية و الإفساد، و المشّاء به هو نقّال الحديث من قوم إلى قوم على وجه الإفساد بينهم.
و المنّاع للخير كثير المنع لفعل الخير أو للخير الّذي ينال أهله.
و المعتدي من الاعتداء و هو المجاوزة للحدّ ظلماً.
و الأثيم هو الّذي كثر إثمه حتّى استقرّ فيه من غير زوال و الإثم هو العمل السيّئ الّذي يبطئ الخير.
و العتلّ بضمّتين هو الفظّ الغليظ الطبع، و فسّر بالفاحش السيّئ الخلق، و بالجافي الشديد الخصومة بالباطل، و بالأكول المنوع للغير، و بالّذي يعتلّ الناس و يجرّهم إلى حبس أو عذاب.
و الزنيم هو الّذي لا أصل له، و قيل: هو الدعيّ الملحق بقوم و ليس منهم، و قيل: هو المعروف باللؤم، و قيل: هو الّذي له علامة في الشرّ يعرف بها و إذا ذكر الشرّ سبق هو إلى الذهن، و المعاني متقاربة.
فهذه صفات تسع رذيلة وصف الله بها بعض أعداء الدين ممّن كان يدعو النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم إلى الطاعة و المداهنة، و هي جماع الرذائل.
و قوله:( عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنِيمٍ ) معناه أنّه بعد ما ذكر من مثالبه و رذائله عتلّ زنيم قيل: و فيه دلالة على أنّ هاتين الرذيلتين أشدّ معايبه.
و الظاهر أنّ فيه إشارة إلى أنّ له خبائث من الصفات لا ينبغي معها أن يطاع في أمر الحقّ و لو اُغمض عن تلك الصفات فإنّه فظّ خشن الطبع لا أصل له لا ينبغي أن يعبأ بمثله في مجتمع بشريّ فليطرد و لا يطع في قول و لا يتّبع في فعل.
قوله تعالى: ( أَنْ كانَ ذا مالٍ وَ بَنِينَ ) الظاهر أنّه بتقدير لام التعليل و هو متعلّق بفعل محصّل من مجموع الصفات الرذيلة المذكورة أي هو يفعل كذا و كذا لأن كان ذا مال و بنين فبطر بذلك و كفر بنعمة الله و تلبّس بكلّ رذيلة خبيثة بدل أن يشكر الله على نعمته و يصلح نفسه، فالآية في إفادة الذمّ و التهكّم تجري مجرى قوله:( أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللهُ الْمُلْكَ ) .
و قيل: إنّه متعلّق بقوله السابق( لا تُطِعْ ) ، و المعنى: لا تطعه لكونه ذا مال و بنين أي لا يحملك كونه ذا مال و بنين على طاعته، و المعنى المتقدّم أقرب و أوسع.
قيل: و لا يجوز تعلّقه بقوله:( قالَ ) في الشرطيّة التالية لأنّ ما بعد الشرط
لا يعمل فيما قبله عند النحاة.
قوله تعالى: ( إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا قالَ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ ) الأساطير جمع اُسطورة و هي القصّة الخرافيّة، و الآية تجري مجرى التعليل لقوله السابق:( لا تُطِعْ ) .
قوله تعالى: ( سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ) الوسم و السمة وضع العلامة، و الخرطوم الأنف، و قيل: إنّ في إطلاق الخرطوم على أنفه و إنّما يطلق في الفيل و الخنزير تهكّماً، و في الآية وعيد على عداوته الشديدة لله و رسوله و ما نزّله على رسوله.
و الظاهر أنّ الوسم على الأنف اُريد به نهاية إذلاله بذلّة ظاهرة يعرفه بها كلّ من رآه فإنّ الأنف ممّا يظهر فيه العزّة و الذلّة كما يقال: شمخ فلان بأنفه و حمي فلان أنفه و أرغمت أنفه و جدع أنفه.
و الظاهر أنّ الوسم على الخرطوم ممّا سيقع يوم القيامة لا في الدنيا و إن تكلّف بعضهم في توجيه حمله على فضاحته في الدنيا.
قوله تعالى: ( إِنَّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ - إلى قوله -كَالصَّرِيمِ ) البلاء الاختبار و إصابة المصيبة، و الصرم قطع الثمار من الأشجار، و الاستثناء عزل البعض من حكم الكلّ و أيضاً الاستثناء قول إن شاء الله عند القطع بقول و ذلك أنّ الأصل فيه الاستثناء فالأصل في قولك: أخرج غداً إن شاء الله هو أخرج غداً إلّا أن يشاء الله أن لا أخرج، و الطائف العذاب الّذي يأتي بالليل، و الصريم الشجر المقطوع ثمره، و قيل: الليل الأسود، و قيل: الرمل المقطوع من سائر الرمل و هو لا ينبت شيئاً و لا يفيد فائدة.
الآيات أعني قوله:( إِنَّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ ) إلى تمام سبع عشرة آية وعيد لمكذّبي النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم الرامين له بالجنون، و في التشبيه و التنظير دلالة على أنّ هؤلاء المكذّبين معذّبون لا محالة و العذاب الواقع عليهم قائم على ساقه، غير أنّهم غافلون و سيعلمون، فهم مولعون اليوم بجمع المال و تكثير البنين
مستكبرون بها معتمدون عليها و على سائر الأسباب الظاهريّة الّتي توافقهم و تشايع أهواءهم من غير أن يشكروا ربّهم على هذه النعم و يسلكوا سبيل الحقّ و يعبدوا ربّهم حتّى يأتيهم الأجل و يفاجئهم عذاب الآخرة أو عذاب دنيويّ من عنده كما فاجأهم يوم بدر فيروا انقطاع الأسباب عنهم و أنّ المال و البنين سدىً لا ينفعهم شيئاً كما شاهد نظير ذلك أصحاب الجنّة من جنّتهم و سيندمون على صنيعهم و يرغبون إلى ربّهم و لا يرد ذلك عذاب الله كما ندم أصحاب الجنّة و تلاوموا و رغبوا إلى ربّهم فلم ينفعهم ذلك شيئاً كذلك العذاب و لعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، هذا على تقدير اتّصال الآيات بما قبلها و نزولها معها.
و أمّا على ما رووا أنّ الآيات نزلت في القحط و السنة الّذي أصاب أهل مكّة و قريشاً إثر دعاء النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم عليهم بقوله: اللّهمّ اشدد وطأتك على مضر و اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، فالمراد بالبلاء إصابتهم بالقحط و تناظر قصّتهم قصّة أصحاب الجنّة غير أنّ في انطباق ما في آخر قصّتهم من قوله:( فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ ) إلخ، على قصّة أهل مكّة خفاء.
و كيف كان فالمعنى:( إِنَّا بَلَوْناهُمْ ) أصبناهم بالبليّة( كَما بَلَوْنا ) و أصبنا بالبليّة( أَصْحابَ الْجَنَّةِ ) و كانوا قوماً من اليمن و جنّتهم فيها و سيأتي إن شاء الله قصّتهم في البحث الروائيّ الآتي( إِذْ ) ظرف لبلونا( أَقْسَمُوا ) و حلفوا( لَيَصْرِمُنَّها ) أي ليقطعنّ و يقطفنّ ثمار جنّتهم( مُصْبِحِينَ ) داخلين في الصباح و كأنّهم ائتمروا و تشاوروا ليلاً فعزموا على الصرم صبيحة ليلتهم( وَ لا يَسْتَثْنُونَ ) لم يقولوا إلّا أن يشاء الله اعتماداً على أنفسهم و اتّكاء على ظاهر الأسباب. أو المعنى: قالوا و هم لا يعزلون نصيباً من ثمارهم للفقراء و المساكين.
( فَطافَ عَلَيْها ) على الجنّة( طائِفٌ ) أي بلاء يطوف عليها و يحيط بها ليلاً( مِنْ ) ناحية( رَبِّكَ، فَأَصْبَحَتْ ) و صارت الجنّة( كَالصَّرِيمِ ) و هو الشجر المقطوع ثمره أو المعنى: فصارت الجنّة كالليل الأسود لمّا اسودّت بإحراق النار الّتي أرسلها الله إليها أو المعنى: فصارت الجنّة كالقطعة من الرمل لا نبات بها و لا فائدة.
قوله تعالى: ( فَتَنادَوْا مُصْبِحِينَ - إلى قوله -قادِرِينَ ) التنادي نداء بعض القوم بعضاً، و الإصباح الدخول في الصباح، و صارمين من الصرم بمعنى قطع الثمار من الشجرة، و المراد به في الآية القاصدون لقطع الثمار، و الحرث الزرع و الشجر، و الخفت الإخفاء و الكتمان، و الحرد المنع و قادرين من القدر بمعنى التقدير.
و المعنى:( فَتَنادَوْا ) أي فنادى بعض القوم بعضاً( مُصْبِحِينَ ) أي و الحال أنّهم داخلون في الصباح( أَنِ اغْدُوا عَلى حَرْثِكُمْ ) تفسير للتنادي أي بكّروا مقبلين على جنّتكم - فاغدوا أمر بمعنى بكّروا مضمّن معنى أقبلوا و لذا عدّي بعلى و لو كان غير مضمّن عدّي بإلى كما في الكشّاف -( إِنْ كُنْتُمْ صارِمِينَ ) أي قاصدين عازمين على الصرم و القطع.
( فانطلقوا ) و ذهبوا إلى جنّتهم( وَ هُمْ يَتَخافَتُونَ ) أي و الحال أنّهم يأتمرون فيما بينهم بطريق المخافتة و المكاتمة( أَنْ لا يَدْخُلَنَّهَا ) أي الجنّة( الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ) أي أخفوا ورودكم الجنّة للصرم من المساكين حتّى لا يدخلوا عليكم فيحملكم ذلك على عزل نصيب من الثمر المصروم لهم( وَ غَدَوْا ) و بكّروا إلى الجنّة( عَلى حَرْدٍ ) أي على منع للمساكين( قادِرِينَ ) مقدّرين في أنفسهم أنّهم سيصرمونها و لا يساهمون المساكين بشيء منها.
قوله تعالى: ( فَلَمَّا رَأَوْها قالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ) أي فلمّا رأوا الجنّة و شاهدوها و قد أصبحت كالصريم بطواف طائف من عندالله قالوا: إنّا لضالّون عن الصواب في غدوّنا إليها بقصد الصرم و منع المساكين.
و قيل: المراد إنّا لضالّون طريق جنّتنا و ما هي بها.
و قوله:( بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ) إضراب عن سابقه أي ليس مجرّد الضلال عن الصواب بل حرمنا الزرع.
قوله تعالى: ( قالَ أَوْسَطُهُمْ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لا تُسَبِّحُونَ - إلى قوله -راغِبُونَ ) أي( قالَ أَوْسَطُهُمْ ) أي أعدلهم طريقاً و ذلك أنّه ذكّرهم بالحقّ و إن تبعهم في العمل
و قيل: المراد أوسطهم سنّا و ليس بشيء( أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ ) و قد كان قال لهم ذلك و إنّما لم يذكر قبل في القصّة إيجازاً بالتعويل على ذكره ههنا.
( لَوْ لا تُسَبِّحُونَ ) المراد بتسبيحهم له تعالى تنزيههم له من الشركاء حيث اعتمدوا على أنفسهم و على سائر الأسباب الظاهريّة فأقسموا ليصرمنّها مصبحين و لم يستثنوا لله مشيّة فعزلوه تعالى عن السببيّة و التأثير و نسبوا التأثير إلى أنفسهم و سائر الأسباب الظاهريّة، و هو إثبات للشريك، و لو قالوا: لنصرمنّها مصبحين إلّا أن يشاء الله كان معنى ذلك نفي الشركاء و أنّهم إن لم يصرموا كان لمشيّة من الله و إن صرموا كان ذلك بإذن من الله فللّه الأمر وحده لا شريك له.
و قيل: المراد بتسبيحهم لله ذكر الله تعالى و توبتهم إليه حيث نووا أن يصرموها و يحرموا المساكين منها، و له وجه على تقدير أن يراد بالاستثناء عزل نصيب من الثمار للمساكين.
قوله تعالى: ( قالُوا سُبْحانَ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ ) تسبيح منهم لله سبحانه إثر توبيخ أوسطهم لهم، أي ننزّه الله تنزيهاً من الشركاء الّذين أثبتناهم فيما حلفنا عليه فهو ربّنا الّذي يدبّر بمشيّته اُمورنا لأنّا كنّا ظالمين في إثباتنا الشركاء فهو تسبيح و اعتراف بظلمهم على أنفسهم في إثبات الشركاء.
و على القول الآخر توبة و اعتراف بظلمهم على أنفسهم و على المساكين.
قوله تعالى: ( فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ ) أي يلوم بعضهم بعضاً على ما ارتكبوه من الظلم.
قوله تعالى: ( قالُوا يا وَيْلَنا - إلى قوله -راغِبُونَ ) الطغيان تجاوز الحدّ و ضمير( مِنْها ) للجنّة باعتبار ثمارها و المعنى: قالوا يا ويلنا إنّا كنّا متجاوزين حدّ العبوديّة إذ أثبتنا شركاء لربّنا و لم نوحّده، و نرجو من ربّنا أن يبدلنا خيراً من هذه الجنّة الّتي طاف عليها طائف منه لأنّا راغبون إليه معرضون عن غيره.
قوله تعالى: ( كَذلِكَ الْعَذابُ وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ ) العذاب مبتدأ مؤخّر، و كذلك خبر مقدّم أي إنّما يكون العذاب على ما وصفناه في قصّة
أصحاب الجنّة و هو أنّ الإنسان يمتحن بالمال و البنين فيطغى مغترّاً بذلك فيستغني بنفسه و ينسى ربّه و يشرك بالأسباب الظاهريّة و بنفسه و يجترئ على المعصية و هو غافل عمّا يحيط به من وبال عمله و يهيّؤ له من العذاب كذلك حتّى إذا فاجأه العذاب و برز له بأهول وجوهه و أمرّها انتبه من نومة الغفلة و تذكّر ما جاءه من النصح قبلاً و ندم على ما فرّط بالطغيان و الظلم و سأل الله أن يعيد عليه النعمة فيشكر كما انتهى إليه أمر أصحاب الجنّة، ففي ذلك إعطاء الضابط بالمثال.
و قوله:( وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ ) لأنّه ناش عن قهر إلهي لا يقوم له شيء لا رجاء للتخلّص منه و لو بالموت و الفناء كما في شدائد الدنيا، محيط بالإنسان من جميع أقطار وجوده لا كعذاب الدنيا دائم لا انتهاء لأمده كما في الابتلاءات الدنيويّة.
( بحث روائي)
في المعاني، بإسناده عن سفيان بن سعيد الثوريّ عن الصادقعليهالسلام في تفسير الحروف المقطّعة في القرآن قال: و أمّا ن فهو نهر في الجنّة قال الله عزّوجلّ: اجمد فجمد فصار مداداً ثمّ قال للقلم: اكتب فسطر القلم في اللوح المحفوظ ما كان و ما هو كائن إلى يوم القيامة فالمداد مداد من نور و القلم قلم من نور و اللوح لوح من نور.
قال سفيان: فقلت له: يا بن رسول الله بيّن أمر اللوح و القلم و المداد فضل بيان و علّمني ممّا علّمك الله فقال: يا ابن سعيد لو لا أنّك أهل للجواب ما أجبتك فنون ملك يؤدّي إلى القلم و هو ملك، و القلم يؤدّي إلى اللّوح و هو ملك، و اللّوح يؤدّي إلى إسرافيل و إسرافيل يؤدّي إلى ميكائيل و ميكائيل يؤدّي إلى جبرائيل و جبرائيل يؤدّي إلى الأنبياء و الرسل. قال: ثمّ قال: قم يا سفيان فلا آمن عليك.
و فيه، بإسناده عن إبراهيم الكرخيّ قال: سألت جعفر بن محمّدعليهالسلام عن اللّوح و القلم قال: هما ملكان.
و فيه، بإسناده عن الأصبغ بن نباتة عن أميرالمؤمنينعليهالسلام :( ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ ) القلم قلم من نور و كتاب من نور في لوح محفوظ يشهده المقرّبون و كفى بالله شهيداً.
أقول: و في المعاني المتقدّمة روايات اُخرى عن أئمّة أهل البيتعليهمالسلام ، و قد تقدّم في ذيل قوله تعالى:( هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ) الجاثية: 29، حديث القمّيّ عن عبدالرحيم القصير عن الصادقعليهالسلام في اللّوح و القلم و فيه: ثمّ ختم على فم القلم فلم ينطق بعد ذلك و لا ينطق أبداً و هو الكتاب المكنون الّذي منه النسخ كلّها.
و في الدرّ المنثور، أخرج ابن جرير عن معاوية بن قرّة عن أبيه قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم :( ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ ) قال: لوح من نور و قلم من نور يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة.
أقول: و في معناه روايات اُخر، و قوله: يجري بما هو كائن إلخ، أي منطبق على متن الكائنات من دون أن يتخلّف شيء منها عمّا كتب هناك و نظيره ما في رواية أبي هريرة: ثمّ ختم علي في القلم فلم ينطق و لا ينطق إلى يوم القيامة.
و في المعاني، بإسناده عن أبي الجارود عن أبي جعفرعليهالسلام في قول الله عزّوجلّ:( وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) قال: هو الإسلام.
و في تفسير القمّيّ، عن أبي الجارود عن أبي جعفرعليهالسلام في قوله:( وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) قال: على دين عظيم.
أقول: يريد اشتمال الدين و الإسلام على كمال الخُلق و استنانهصلىاللهعليهوآلهوسلم به، و في الرواية المعروفة عنهصلىاللهعليهوآلهوسلم : بعثت لاُتمّم مكارم الأخلاق.
و في المجمع، بإسناده عن الحاكم بإسناده عن الضحّاك قال: لمّا رأت قريش تقديم النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم عليّاً و إعظامه له نالوا من علي و قالوا: قد افتتن به محمّد فأنزل الله تعالى:( ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ ) قسم أقسم الله به( ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَ إِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ (يعني القرآن) - إلى قوله -
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ) وهم النفر الّذين قالوا ما قالوا( وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ) يعني عليّ بن أبي طالب.
أقول: و رواه في تفسير البرهان، عن محمّد بن العبّاس بإسناده إلى الضحّاك و ساق نحواً ممّا مرّ و في آخره: و سبيله عليّ بن أبي طالب.
و فيه في قوله تعالى:( وَ لا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ ) إلخ، قيل: يعني الوليد بن المغيرة عرض على النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم المال ليرجع عن دينه، و قيل: يعني الأخنس بن شريق عن عطاء، و قيل: يعني الأسود بن عبد يغوث: عن مجاهد.
أقول: و في ذلك روايات في الدرّ المنثور و غيره تركنا إيرادها من أرادها فليراجع جوامع الروايات.
و فيه، عن شدّاد بن أوس قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : لا يدخل الجنّة جوّاظ و لا جعظريّ و لا عتلّ زنيم. قلت: فما الجوّاظ؟ قال: كلّ جمّاع منّاع. قلت: فما الجعظريّ؟ قال: الفظّ الغليظ. قلت: فما العتلّ الزنيم؟ قال: كلّ رحيب الجوف سيّيء الخلق أكول شروب غشوم ظلوم زنيم.
و فيه، في معنى الزنيم: قيل: هو الّذي لا أصل له.
و فيه، في تفسير القمّيّ في قوله:( عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنِيمٍ ) قال: العتلّ العظيم الكفر الزنيم الدعيّ.
و فيه، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرعليهالسلام : في قوله:( إِنَّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ ) إنّ أهل مكّة ابتلوا بالجوع كما ابتلي أصحاب الجنّة و هي كانت في الدنيا و كانت باليمن يقال له الرضوان على تسعة أميال من صنعاء.
و فيه، بإسناده إلى ابن عبّاس: أنّه قيل له إنّ قوماً من هذه الاُمّة يزعمون أنّ العبد يذنب فيحرم به الرزق، فقال ابن عبّاس: فو الله الّذي لا إله إلّا هو هذا أنور في كتاب الله من الشمس الضاحية ذكره الله في سورة ن و القلم.
إنّه كان شيخ و كان له جنّة و كان لا يدخل إلى بيته ثمرة منها و لا إلى منزله حتّى يعطي كلّ ذي حقّ حقّه فلمّا قبض الشيخ ورثه بنوه و كان له خمس من البنين
فحملت جنّتهم في تلك السنة الّتي هلك فيها أبوهم حملاً لم يكن حملته قبل ذلك فراحوا الفتية إلى جنّتهم بعد صلاة العصر فأشرفوا على ثمرة و رزق فاضل لم يعاينوا مثله في حياة أبيهم.
فلمّا نظروا إلى الفضل طغوا و بغوا و قال بعضهم لبعض: إنّ أبانا كان شيخاً كبيراً قد ذهب عقله و خرف فهلمّوا نتعاقد فيما بيننا أن لا نعطي أحداً من فقراء المسلمين في عامنا شيئاً حتّى نستغني و يكثر أموالنا ثمّ نستأنف الصنيعة فيما استقبل من السنين المقبلة فرضي بذلك منهم أربعة و سخط الخامس و هو الّذي قال الله:( قالَ أَوْسَطُهُمْ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لا تُسَبِّحُونَ ) .
فقال الرجل: يا ابن عبّاس كان أوسطهم في السنّ؟ فقال: لا بل كان أصغرهم سنّاً و أكبرهم عقلاً و أوسط القوم خير القوم، و الدليل عليه في القرآن قوله: إنكم يا اُمّة محمّد أصغر الاُمم و خير الاُمم قوله عزّوجلّ:( وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً ) .
قال لهم أوسطهم: اتّقوا و كونوا على منهاج أبيكم تسلموا و تغنموا فبطشوا به و ضربوه ضرباً مبرحاً فلمّا أيقن الأخ منهم أنّهم يريدون قتله دخل معهم في مشورتهم كارهاً لأمرهم غير طائع.
فراحوا إلى منازلهم ثمّ حلفوا بالله ليصرمنّ إذا أصبحوا و لم يقولوا إن شاء الله فابتلاهم الله بذلك الذنب و حال بينهم و بين ذلك الرزق الّذي كانوا أشرفوا عليه فأخبر عنهم في الكتاب فقال:( إِنَّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحِينَ وَ لا يَسْتَثْنُونَ فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَ هُمْ نائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ) قال: كالمحترق.
فقال الرجل: يا ابن عبّاس ما الصريم؟ قال: الليل المظلم، ثمّ قال: لا ضوء له و لا نور.
فلمّا أصبح القوم( فَتَنادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صارِمِينَ ) قال:( فَانْطَلَقُوا وَ هُمْ يَتَخافَتُونَ ) قال الرجل: و ما التخافت يا ابن عبّاس؟ قال: يتشاورون
فيشاور بعضهم بعضاً لكيلاً يسمع أحد غيرهم فقالوا:( لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَ غَدَوْا عَلى حَرْدٍ قادِرِينَ ) في أنفسهم أن يصرموها و لا يعلمون ما قد حلّ بهم من سطوات الله و نقمته.
( فَلَمَّا رَأَوْها ) و ما قد حلّ بهم( قالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ) فحرمهم الله ذلك الرزق بذنب كان منهم و لم يظلمهم شيئاً.
( قالَ أَوْسَطُهُمْ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لا تُسَبِّحُونَ قالُوا سُبْحانَ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ ) قال: يلومون أنفسهم فيما عزموا عليه( قالُوا يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا طاغِينَ عَسى رَبُّنا أَنْ يُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إِنَّا إِلى رَبِّنا راغِبُونَ ) فقال الله:( كَذلِكَ الْعَذابُ وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ ) .
أقول: و قد ورد ما يقرب من مضمون هذا الحديث و الّذي قبله في روايات اُخر و في بعض الروايات أنّ الجنّة كانت لرجل من بني إسرائيل ثمّ مات و ورثه بنوه فكان من أمرهم ما كان.
( سورة القلم الآيات 34 - 52)
إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ( 34 ) أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ( 35 ) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ( 36 ) أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ( 37 ) إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ( 38 ) أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ( 39 ) سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ( 40 ) أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ( 41 ) يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ( 42 ) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ( 43 ) فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ( 44 ) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ( 45 ) أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ( 46 ) أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ( 47 ) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ( 48 ) لَّوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ( 49 ) فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ( 50 ) وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ( 51 ) وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ( 52 )
( بيان)
فيها تذييل لما تقدّم من الوعيد لمكذّبي النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم و تسجيل العذاب عليهم في الآخرة إذ المتّقون في جنّات النعيم، و تثبيت أنّهم و المتّقون لا يستوون بحجّة قاطعة فليس لهم أن يرجوا كرامة من الله و هم مجرمون فما يجدونه من نعم الدنيا استدراج و إملاء.
و فيها تأكيد أمر النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم بالصبر لحكم ربّه.
قوله تعالى: ( إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ) بشرى و بيان لحال المتّقين في الآخرة قبال ما بيّن من حال المكذّبين فيها.
و في قوله:( عِنْدَ رَبِّهِمْ ) دون أن يقال: عند الله إشارة إلى رابطة التدبير و الرحمة بينهم و بينه سبحانه و أنّ لهم ذلك قبال قصرهم الربوبيّة فيه تعالى و إخلاصهم العبوديّة له.
و إضافة الجنّات إلى النعيم و هو النعمة للإشارة إلى أنّ ما فيها من شيء نعمة لا تشوبها نقمة و لذّة لا يخالطها ألم، و سيجيء إن شاء الله في تفسير قوله تعالى:( ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ) التكاثر: 8، أنّ المراد بالنعيم الولاية.
قوله تعالى: ( أَ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ) تحتمل الآية في بادئ النظر أن تكون مسوقة حجّة على المعاد كقوله تعالى:( أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ) ص: 28، و قد تقدّم تفسيره.
و أن تكون ردّاً على قول من قال منهم للمؤمنين: لو كان هناك بعث و إعادة لكنّا منعّمين كما في الدنيا و قد حكى سبحانه ذلك عن قائلهم:( وَ ما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً وَ لَئِنْ رُجِعْتُ إِلى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنى ) حم السجدة: 50.
ظاهر سياق الآيات التالية الّتي تردّ عليهم الحكم بالتساوي هو الاحتمال الثاني، و هو الّذي رووه أنّ المشركين لمّا سمعوا حديث البعث و المعاد قالوا: إن صحّ ما
يقوله محمّد و الّذين آمنوا معه لم تكن حالنا إلّا أفضل من حالهم كما في الدنيا و لا أقلّ من أن تتساوى حالنا و حالهم.
غير أنّه يرد عليه أنّ الآية لو سيقت لردّ قولهم، سنساويهم في الآخرة أو نزيد عليهم كما في الدنيا، كان مقتضى التطابق بين الردّ و المردود أن يقال: أ فنجعل المجرمين كالمسلمين و قد عكس.
و التدبّر في السياق يعطي أنّ الآية مسوقة لردّ دعواهم التساوي لكن لا من جهة نفي مساواتهم على إجرامهم للمسلمين بل تزيد على ذلك بالإشارة إلى أنّ كرامة المسلمين تأبى أن يساويهم المجرمون كأنّه قيل: إنّ قولكم: سنتساوى نحن و المسلمون باطل فإنّ الله لا يرضى أن يجعل المسلمين بما لهم من الكرامة عنده كالمجرمين و أنتم مجرمون.
فالآية تقيم الحجّة على عدم تساوي الفريقين من جهة منافاته لكرامة المسلمين عليه تعالى لا من جهة منافاة مساواة المجرمين للمسلمين عدله تعالى.
و المراد بالإسلام تسليم الأمر لله فلا يتّبع إلّا ما أراده سبحانه من فعل أو ترك يقابله الاجرام و هو اكتساب السيّئة و عدم التسليم.
و الآية و ما بعدها إلى قوله:( أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ) في مقام الردّ لحكمهم بتساوي المجرمين و المسلمين حالاً يوم القيامة تورد محتملات هذا الحكم من حيث منشائه في صور استفهامات إنكارية و تردّها.
و تقرير الحجّة: أنّ كون المجرمين كالمسلمين يوم القيامة على ما حكموا به إمّا أن يكون من الله تعالى موهبة و رحمة و إمّا أن لا يكون منه.
و الأوّل إمّا أن يدلّ عليه دليل العقل و لا دليل عليه كذلك و ذلك قوله:( ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) .
و إمّا أن يدلّ عليه النقل و ليس كذلك و هو قوله:( أَمْ لَكُمْ كِتابٌ ) إلخ، و إمّا أن يكون لا لدلالة عقل أو نقل بل عن مشافهة بينهم و بين الله سبحانه عاهدوه و
واثقوه على أن يسوّي بينهما و ليس كذلك فهذه ثلاثة احتمالات.
و إمّا أن لا يكون من الله فإمّا أن يكون حكمهم بالتساوي حكماً جدّيّاً أو لا يكون فإن كان جدّيّاً فإمّا أن يكون التساوي الّذي يحكمون به مستنداً إلى أنفسهم بأن يكون لهم قدرة على أن يصيروا يوم القيامة كالمسلمين حالاً و إن لم يشإ الله ذلك و ليس كذلك و هو قوله:( سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ ) أو يكون القائم بهذا الأمر المتصدّي له شركاؤهم و لا شركاء و هو قوله:( أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكائِهِمْ ) إلخ.
و إمّا أن يكون ذلك لأنّ الغيب عندهم و الاُمور الّتي ستستقبل الناس قدرها و قضاؤها منوطان بمشيّتهم تكون و تقع كيف يكتبون فكتبوا لأنفسهم المساواة مع المسلمين، و ليس كذلك و لا سبيل لهم إلى الغيب و ذلك قوله:( أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ) و هذه ثلاثة احتمالات.
و إن لم يكن حكمهم بالمساواة حكماً جدّيّاً بل إنّما تفوّهوا بهذا القول تخلّصاً و فراراً من اتّباعك على دعوتك لأنّك تسألهم أجراً على رسالتك و هدايتك لهم إلى الحقّ فهم مثقلون من غرامته، و ليس كذلك، و هو قوله:( أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ) و هذا سابع الاحتمالات.
هذا ما يعطيه التدبّر في الآيات في وجه ضبط ما فيها من الترديد و قد ذكروا في وجه الضبط غير ذلك من أراد الوقوف عليه فليراجع المطوّلات.
فقوله:( ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) مسوق للتعجّب من حكمهم بكون المجرمين يوم القيامة كالمسلمين، و هو إشارة إلى تأبّي العقل عن تجويز التساوي، و محصّله نفي حكم العقل بذلك إذ معناه: أيّ شيء حصل لكم من اختلال الفكر و فساد الرأي حتّى حكمتم بذلك.؟
قوله تعالى: ( أَمْ لَكُمْ كِتابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَما تَخَيَّرُونَ ) إشارة إلى انتفاء الحجّة على حكمهم بالتساوي من جهة السمع كما أنّ الآية السابقة كانت
إشارة إلى انتفائها من جهة العقل.
و المراد بالكتاب الكتاب السماويّ النازل من عندالله و هو حجّة، و درس الكتاب قراءته، و التخيّر الاختيار، و قوله:( إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَما تَخَيَّرُونَ ) في مقام المفعول لتدرسون و الاستفهام إنكاريّ.
و المعنى: بل أ لكم كتاب سماويّ تقرؤن فيه إنّ لكم في الآخرة - أو مطلقاً - لما تختارونه فاخترتم السعادة و الجنّة.
قوله تعالى: ( أَمْ لَكُمْ أَيْمانٌ عَلَيْنا بالِغَةٌ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَما تَحْكُمُونَ ) إشارة إلى انتفاء أن يملكوا الحكم بعهد و يمين شفاهيّ لهم على الله سبحانه.
و الأيمان جمع يمين و هو القسم، و البلوغ هو الانتهاء في الكمال فالأيمان البالغة هي المؤكّدة نهاية التوكيد، و قوله:( إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ ) على هذا ظرف مستقرّ متعلّق بمقدّر و التقدير: أم لكم علينا أيمان كائنة إلى يوم القيامة مؤكّدة نهاية التوكيد، إلخ.
و يمكن أن يكون( إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ ) متعلّقاً ببالغة و المراد ببلوغ الأيمان انطباقها على امتداد الزمان حتّى ينتهي إلى يوم القيامة.
و قد فسّروا الإيمان بالعهود و المواثيق فيكون من باب إطلاق اللازم و إرادة الملزوم كناية، و احتمل أن يكون من باب إطلاق الجزء و إرادة الكلّ.
و قوله:( إِنَّ لَكُمْ لَما تَحْكُمُونَ ) جواب القسم و هو المعاهد عليه، و الاستفهام للإنكار.
و المعنى: بل أ لكم علينا عهود أقسمنا فيها إقساماً مؤكّداً إلى يوم القيامة إنّا سلّمنا لكم أنّ لكم لما تحكمون به.
قوله تعالى: ( سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ ) إعراض عن خطابهم و التفات إلى النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم بتوجيه الخطاب لسقوطهم عن درجة استحقاق الخطاب و لذلك أورد بقية السؤالات و هي مسائل أربع في سياق الغيبة أوّلها قوله:( سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ ) و الزعيم القائم بالأمر المتصدّي له، و الاستفهام إنكاريّ.
و المعنى: سل المشركين أيّهم قائم بأمر التسوية الّذي يدّعونه أي إذا ثبت أنّ الله لا يسوّي بين الفريقين لعدم دليل يدلّ عليه فهل الّذي يقوم بهذا الأمر و يتصدّاه هو منهم؟ فأيّهم هو؟ و من الواضح بطلانه لا يتفوّه به إلّا مصاب في عقله.
قوله تعالى: ( أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكائِهِمْ إِنْ كانُوا صادِقِينَ ) ردّ لهم على تقدير أن يكون حكمهم بالتساوي مبنيّاً على دعواهم أنّ لهم آلهة يشاركون الله سبحانه في الربوبيّة سيشفعون لهم عندالله فيجعلهم كالمسلمين و الاستفهام إنكاريّ يفيد نفي الشركاء.
و قوله:( فَلْيَأْتُوا بِشُرَكائِهِمْ ) إلخ، كناية عن انتفاء الشركاء يفيد تأكيد ما في قوله:( أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ ) من النفي.
و قيل: المراد بالشركاء شركاؤهم في هذا القول، و المعنى: أم لهم شركاء يشاركونهم في هذا القول و يذهبون مذهبهم فليأتوا بهم إن كانوا صادقين.
و أنت خبير بأنّ هذا المعنى لا يقطع الخصام.
و قيل: المراد بالشركاء الشهداء و المعنى: أم لهم شهداء على هذا القول فليأتوا بهم إن كانوا صادقين.
و هو تفسير بما لا دليل عليه من جهة اللفظ. على أنّه مستدرك لأنّ هؤلاء الشهداء شهداء على كتاب من عندالله أو وعد بعهد و يمين و قد ردّ كلا الاحتمالين فيما تقدّم.
و قيل: المراد بالشركاء شركاء الاُلوهيّة على ما يزعمون لكنّ المعنىّ من إتيانهم بهم إتيانهم بهم يوم القيامة ليشهدوا لهم أو ليشفعوا لهم عند الله سبحانه.
و أنت خبير بأنّ هذا المعنى أيضاً لا يقطع الخصام.
قوله تعالى: ( يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ وَ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ - إلى قوله -وَ هُمْ سالِمُونَ ) يوم ظرف متعلّق بمحذوف كاذكر و نحوه، و الكشف عن الساق تمثيل في اشتداد الأمر اشتداداً بالغاً لما أنّهم كانوا يشمّرون عن سوقهم إذا اشتدّ الأمر للعمل أو للفرار قال في الكشّاف: فمعنى( يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ ) في معنى يوم يشتدّ الأمر و يتفاقم، و لا كشف ثمّ و لا ساق كما تقول للأقطع الشحيح: يده مغلولة و لا يد
ثمّ و لا غلّ و إنّما هو مثل في البخل انتهى.
و الآية و ما بعدها إلى تمام خمس آيات اعتراض وقع في البين بمناسبة ذكر شركائهم الّذين يزعمون أنّهم سيسعدونهم لو كان هناك بعث و حساب فذكر سبحانه أن لا شركاء لله و لا شفاعة و إنّما يحرز الإنسان سعادة الآخرة بالسجود أي الخضوع لله سبحانه بتوحيد الربوبيّة في الدنيا حتّى يحمل معه صفة الخضوع فيسعد بها يوم القيامة.
و هؤلاء المكذّبون المجرمون لم يسجدوا لله في الدنيا فلا يستطيعون السجود في الآخرة فلا يسعدون و لا تتساوى حالهم و حال المسلمين فيها البتّة بل الله سبحانه يعاملهم في الدنيا لاستكبارهم عن سجوده معاملة الاستدراج و الإملاء حتّى يتمّ لهم شقاؤهم فيردّوا العذاب الأليم في الآخرة.
فقوله:( يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ وَ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ ) معناه اذكر يوم يشتدّ عليهم الأمر و يدعون إلى السجود لله خضوعاً فلا يستطيعون لاستقرار ملكة الاستكبار في سرائرهم و اليوم تبلى السرائر(1) .
و قوله:( خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ) حالان من نائب فاعل يدعون أي حال كون أبصارهم خاشعة و حال كونهم يغشاهم الذلّة بقهر، و نسبة الخشوع إلى الأبصار لظهور أثره فيها.
و قوله:( وَ قَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَ هُمْ سالِمُونَ ) المراد بالسلامة سلامتهم من الآفات و العاهات الّتي لحقت نفوسهم بسبب الاستكبار عن الحقّ فسلبتها التمكّن من إجابة الحقّ أو المراد مطلق استطاعتهم منه في الدنيا.
و المعنى: و قد كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود لله و هم سالمون متمكّنون منه أقوى تمكّن فلا يجيبون إليه.
و قيل: المراد بالسجود الصلاة و هو كما ترى.
قوله تعالى: ( فَذَرْنِي وَ مَنْ يُكَذِّبُ بِهذَا الْحَدِيثِ ) المراد بهذا الحديث القرآن الكريم و قوله:( فَذَرْنِي وَ مَنْ يُكَذِّبُ ) إلخ، كناية عن أنّه يكفيهم وحده و هو غير
____________________
(1) الطارق الآية 9.
تاركهم و فيه نوع تسلية للنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم و تهديد للمشركين.
قوله تعالى: ( سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ ) استئناف فيه بيان كيفيّة أخذه تعالى لهم و تعذيبه إيّاهم المفهوم من قوله:( فَذَرْنِي ) إلخ.
و الاستدراج هو استنزالهم درجة فدرجة حتّى يتمّ لهم الشقاء فيقعوا في ورطة الهلاك و ذلك بأن يؤتيهم الله نعمة بعد نعمة و كلّما اُوتوا نعمة اشتغلوا بها و فرّطوا في شكرها و زادوا نسياناً له و ابتعدوا عن ذكره.
فالاستدراج إيتاؤهم النعمة بعد النعمة الموجب لنزولهم درجة بعد درجة و اقترابهم من ورطة الهلاك، و كونه من حيث لا يعلمون إنّما هو لكونه من طريق النعمة الّتي يحسبونها خيراً و سعادة لا شرّ فيها و لا شقاء.
قوله تعالى: ( وَ أُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ) الإملاء الإمهال، و الكيد ضرب من الاحتيال، و المتين القويّ.
و المعنى: و اُمهلهم حتّى يتوسّعوا في نعمنا بالمعاصي كما يشاؤن إنّ كيدي قويّ.
و النكتة في الالتفات الّذي في( سَنَسْتَدْرِجُهُمْ ) عن التكلّم وحده إلى التكلّم مع الغير الدلالة على العظمة و أنّ هناك موكّلين على هذه النعم الّتي تصبّ عليهم صبّا، و الالتفات في قوله:( وَ أُمْلِي لَهُمْ ) عن التكلّم مع الغير إلى التكلّم وحده لأنّ الإملاء تأخير في الأجل و لم ينسب أمر الأجل في القرآن إلى غير الله سبحانه قال تعالى:( ثُمَّ قَضى أَجَلًا وَ أَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ) الأنعام: 2.
قوله تعالى: ( أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ) المغرم الغرامة، و الإثقال تحميل الثقل، و الجملة معطوفة على قوله:( أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ ) إلخ.
و المعنى: أم تسأل هؤلاء المجرمين - الّذين يحكمون بتساوي المجرمين و المسلمين يوم القيامة - أجراً على دعوتك فهم من غرامة تحملها عليهم مثقلون فيواجهونك بمثل هذا القول تخلّصاً من الغرامة دون أن يكون ذلك منهم قولاً جدّيّاً.
قوله تعالى: ( أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ) ظاهر السياق أن يكون المراد بالغيب غيب الأشياء الّذي منه تنزل الاُمور بقدر محدود فتستقرّ في منصّة الظهور، و المراد
بالكتابة على هذا هو التقدير و القضاء، و المراد بكون الغيب عندهم تسلّطهم عليه و ملكهم له.
فالمعنى: أم بيدهم أمر القدر و القضاء فهم يقضون كما شاؤا فيقضون لأنفسهم أن يساووا المسلمين يوم القيامة.
و قيل: المراد بكون الغيب عندهم علمهم بصحّة ما حكموا به و الكتابة على ظاهر معناه و المعنى: أم عندهم علم بصحّة ما يدّعونه اختصّوا به و لا يعلمه غيرهم فهم يكتبونه و يتوارثونه و ينبغي أن يبرزوه.
و هو بعيد بل مستدرك و الاحتمالات الاُخر المذكورة مغنية عنه.
و إنّما اُخّر ذكر هذا الاحتمال عن غيره حتّى عن قوله:( أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً ) مع أنّ مقتضى الظاهر أن يتقدّم عليه، لكونه أضعف الاحتمالات و أبعدها.
قوله تعالى: ( فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ لا تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نادى وَ هُوَ مَكْظُومٌ ) صاحب الحوت يونس النبيّعليهالسلام و المكظوم من كظم الغيظ إذا تجرّعه و لذا فسّر بالمختنق بالغمّ حيث لا يجد لغيظه شفاء، و نهيهصلىاللهعليهوآلهوسلم عن أن يكون كيونسعليهالسلام و هو في زمن النداء مملوء بالغمّ نهي عن السبب المؤدّي إلى نظير هذا الابتلاء و هو ضيق الصدر و الاستعجال بالعذاب.
و المعنى: فاصبر لقاء ربّك أن يستدرجهم و يملئ لهم و لا تستعجل لهم العذاب لكفرهم و لا تكن كيونس فتكون مثله و هو مملوء غمّاً أو غيظاً ينادي بالتسبيح و الاعتراف بالظلم أي فاصبر و احذر أن تبتلي بما يشبه ابتلاءه، و نداؤه قوله في بطن الحوت:( لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ) كما في سورة الأنبياء.
و قيل: اللّام في( لِحُكْمِ رَبِّكَ ) بمعنى إلى و فيه تهديد لقومه و وعيد لهم أن سيحكم الله بينه و بينهم، و الوجه المتقدّم أنسب لسياق الآيات السابقة.
قوله تعالى: ( لَوْ لا أَنْ تَدارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَراءِ وَ هُوَ مَذْمُومٌ ) في مقام التعليل للنهي السابق:( لا تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ ) و التدارك الإدراك و اللحوق، و فسّرت
النعمة بقبول التوبة، و النبذ الطرح، و العراء الأرض غير المستورة بسقف أو نبات، و الذمّ مقابل المدح.
و المعنى: لو لا أن أدركته و لحقت به نعمة من ربّه و هو أنّ الله قبل توبته لطرح بالأرض العراء و هو مذموم بما فعل.
لا يقال: إنّ الآية تنافي قوله تعالى:( فَلَوْ لا أَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ) الصافّات: 144، فإنّ مدلوله أنّ مقتضى عمله أن يلبث في بطنه إلى يوم القيامة و مقتضى هذه الآية أنّ مقتضاه أن يطرح في الأرض العراء مذموماً و هما تبعتان متنافيتان لا تجتمعان.
فإنّه يقال: الآيتان تحكيان عن مقتضيين مختلفين لكلّ منهما أثر على حدّة فآية الصافّات تذكر أنهعليهالسلام كان مداوماً للتسبيح مستمرّاً عليه طول حياته قبل ابتلائه - و هو قوله: كان من المسبّحين - و لو لا ذلك للبث في بطنه إلى يوم القيامة، و الآية الّتي نحن فيها تدلّ على أنّ النعمة و هو قبول توبته في بطن الحوت شملته فلم ينبذ بالعراء مذموماً.
فمجموع الآيتين يدلّ على أنّ ذهابه مغاضباً كان يقتضي أن يلبث في بطنه إلى يوم القيامة فمنع عنه دوام تسبيحه قبل التقامه و بعده، و قدّر أن ينبذ بالعراء و كان مقتضى عمله أنّ ينبذ مذموماً فمنع من ذلك تدارك نعمة ربّه له فنبذ غير مذموم بل اجتباه الله و جعله من الصالحين فلا منافاة بين الآيتين.
و قد تكرّر في مباحثنا السابقة أنّ حقيقة النعمة الولاية و على ذلك يتعيّن لقوله:( لَوْ لا أَنْ تَدارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ ) معنى آخر.
قوله تعالى: ( فَاجْتَباهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ) تقدّم توضيح معنى الاجتباء و الصلاح في مباحثنا المتقدّمة.
قوله تعالى: ( وَ إِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ ) إن مخفّفة من الثقيلة، و الزلق هو الزلل، و الإزلاق الإزلال و هو الصرع كناية عن القتل و الإهلاك.
و المعنى: أنّه قارب الّذين كفروا أن يصرعوك بأبصارهم لمّا سمعوا الذكر.
و المراد بإزلاقه بالأبصار و صرعة بها - على ما عليه عامّة المفسّرين - الإصابة بالأعين، و هو نوع من التأثير النفسانيّ لا دليل على نفيه عقلاً و ربّما شوهد من الموارد ما يقبل الانطباق عليه، و قد وردت في الروايات فلا موجب لإنكاره.
و قيل: المعنى أنّهم ينظرون إليك إذا سمعوا منك الذكر الّذي هو القرآن نظراً مليئاً بالعداوة و البغضاء يكادون يقتلونك بحديد نظرهم.
قوله تعالى: ( وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَ ما هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ ) رميهم له بالجنون عند ما سمعوا الذكر دليل على أنّ مرادهم به رمي القرآن بأنّه من إلقاء الشياطين، و لذا ردّ قولهم بأنّ القرآن ليس إلّا ذكراً للعالمين.
و قد ردّ قولهم:( إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ) في أوّل السورة بقوله:( ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ) و به ينطبق خاتمة السورة على فاتحتها.
( بحث روائي)
في المعاني، بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي الحسنعليهالسلام في قوله عزّوجلّ:( يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ وَ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ ) قال: حجاب من نور يكشف فيقع المؤمنون سجّداً و تدمج أصلاب المنافقين فلا يستطيعون السجود.
و فيه، بإسناده عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: سألته عن قول الله عزّوجلّ:( يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ ) قال: كشف إزاره عن ساقه فقال: سبحان ربّي الأعلى.
أقول: قال الصدوق بعد نقل الحديث: قوله: سبحان ربّي الأعلى تنزيه الله سبحانه أن يكون له ساق. انتهى. و في هذا المعنى رواية اُخرى عن الحلبي عن أبي عبداللهعليهالسلام .
و فيه، بإسناده عن معلّى بن خنيس قال: قلت لأبي عبداللهعليهالسلام : ما يعني بقوله:
( وَ قَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَ هُمْ سالِمُونَ ) قال: و هم مستطيعون.
و في الدرّ المنثور، أخرج البخاريّ و ابن المنذر و ابن مردويه عن أبي سعيد: سمعت النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم يقول: يكشف ربّنا عن ساقه فيسجد له كلّ مؤمن و مؤمنة، و يبقى من كان يسجد في الدنيا رياء و سمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً.
و فيه، أخرج ابن مندة في الردّ على الجهمية عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم :( يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ ) قال: يكشف الله عن ساقه.
و فيه، أخرج إسحاق بن راهويه في مسنده و عبد بن حميد و ابن أبي الدنيا و الطبراني و الآجريّ في الشريعة و الدارقطنيّ في الرؤية و الحاكم و صحّحه و ابن مردويه و البيهقي في البعث عن عبدالله بن مسعود عن النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: يجمع الله الناس يوم القيامة و ينزل الله في ظلل من الغمام فينادي منادياً أيّها الناس أ لم ترضوا من ربّكم( الّذي ) خلقكم و صوّركم و رزقكم أن يولّي كلّ إنسان منكم ما كان يعبد في الدنيا و يتولّى؟ أ ليس ذلك من ربّكم عدلاً؟ قالوا: بلى.
قال: فينطلق كلّ إنسان منكم إلى ما كان يعبد في الدنيا و يتمثّل لهم ما كانوا يعبدون في الدنيا فيتمثّل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى، و يتمثّل لمن كان يعبد عزيزاً شيطان عزيز حتّى يمثّل لهم الشجرة و العود و الحجر.
و يبقى أهل الإسلام جثوماً فيتمثّل لهم الربّ عزّوجلّ فيقول لهم: ما لكم لم تنطلقوا كما انطلق الناس؟ فيقولون: إنّ لنا ربّاً ما رأيناه بعد فيقول: فبم تعرفون ربّكم إن رأيتموه؟ قالوا: بيننا و بينه علامة إن رأيناه عرفناه؟ قال: و ما هي؟ قالوا: يكشف عن ساق.
فيكشف عند ذلك عن ساق فيخرّ كلّ من كان يسجد طائعاً ساجداً و يبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر يريدون السجود فلا يستطيعون. الحديث.
أقول: و الروايات الثلاث مبنيّة على التشبيه المخالف للبراهين العقليّة و نصّ الكتاب العزيز فهي مطروحة أو مؤوّلة.
و في الكافي، بإسناده عن سفيان بن السمط قال: قال أبوعبداللهعليهالسلام : إنّ الله
إذا أراد بعبد خيراً فأذنب ذنباً أتبعه بنقمة و ذكّره الاستغفار، فإذا أراد بعبد شرّاً فأذنب ذنباً أتبعه بنعمة لينسيه الاستغفار و يتمادى بها، و هو قول الله عزّوجلّ:( سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ ) بالنعم و المعاصي.
أقول: و قد تقدّم بعض روايات الاستدراج في ذيل قوله تعالى:( سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ ) الآية 182 من سورة الأعراف.
و في تفسير القمّيّ في قوله تعالى:( إِذْ نادى وَ هُوَ مَكْظُومٌ ) في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرعليهالسلام : يقول: مغموم.
و فيه،: في قوله تعالى:( لَوْ لا أَنْ تَدارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ ) قال: النعمة الرحمة.
و فيه،: في قوله تعالى:( لَنُبِذَ بِالْعَراءِ ) قال: الموضع الّذي لا سقف له.
و في الدرّ المنثور في قوله تعالى:( وَ إِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) أخرج البخاري عن ابن عبّاس أنّ رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: العين حقّ.
و فيه، أخرج أبونعيم في الحلية عن جابر أنّ النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: العين تدخل الرجل القبر و الجمل القدر.
أقول: و هناك روايات تطبق الآيات السابقة على الولاية و هي من الجري دون التفسير و لذلك لم نوردها.
( سورة الحاقّة مكّيّة و هي اثنتان و خمسون آية)
( سورة الحاقّة الآيات 1 - 12)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَاقَّةُ ( 1 ) مَا الْحَاقَّةُ ( 2 ) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ( 3 ) كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ( 4 ) فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ( 5 ) وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ( 6 ) سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ( 7 ) فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ ( 8 ) وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ ( 9 ) فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً ( 10 ) إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ( 11 ) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ( 12 )
( بيان)
السورة تذكر الحاقّة و هي القيامة و قد سمّتها أيضاً بالقارعة و الواقعة.
و قد ساقت الكلام فيها في فصول ثلاثة: فصل تذكر فيه إجمالاً الاُمم الّذين كذّبوا بها فأخذهم الله أخذة رابية، و فصل تصف فيه الحاقّة و انقسام الناس فيها إلى أصحاب اليمين و أصحاب الشمال و اختلاف حالهم بالسعادة و الشقاء، و فصل تؤكّد فيه صدق القرآن في إنبائه بها و أنّه حقّ اليقين، و السورة مكّيّة بشهادة سياق آياتها.
قوله تعالى: ( الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَ ما أَدْراكَ مَا الْحَاقَّةُ ) المراد بالحاقّة القيامة الكبرى سمّيت بها لثبوتها ثبوتاً لا مردّ له و لا ريب فيه، من حقّ الشيء بمعنى ثبت و تقرّر تقرّراً واقعياً.
و( مَا ) في( مَا الْحَاقَّةُ ) استفهاميّة تفيد تفخيم أمرها، و لذلك بعينه وضع الظاهر موضع الضمير و لم يقل: ما هي، و الجملة الاستفهاميّة خبر الحاقّة.
فقوله:( الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ ) مسوق لتفخيم أمر القيامة يفيد تفخيم أمرها و إعظام حقيقتها إفادة بعد إفادة.
و قوله:( وَ ما أَدْراكَ مَا الْحَاقَّةُ ) خطاب بنفي العلم بحقيقة اليوم و هذا التعبير كناية عن كمال أهمّيّة الشيء و بلوغه الغاية في الفخامة و لعلّ هذا هو المراد ممّا نقل عن ابن عبّاس: أنّ ما في القرآن من قوله تعالى:( ما أَدْراكَ ) فقد أدراه و ما فيه من قوله:( ما يُدْرِيكَ ) فقد طوى عنه، يعني أنّ( ما أَدْراكَ ) كناية و( ما يُدْرِيكَ ) تصريح.
قوله تعالى: ( كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَ عادٌ بِالْقارِعَةِ ) المراد بالقارعة القيامة و سمّيت بها لأنّها تقرع و تدكّ السماوات و الأرض بتبديلها و الجبال بتسييرها و الشمس بتكويرها و القمر بخسفها و الكواكب بنثرها و الأشياء كلّها بقهرها على ما نطقت به الآيات، و كان مقتضى الظاهر أن يقال: كذّبت ثمود و عاد بها فوضع القارعة موضع الضمير لتأكيد تفخيم أمرها.
و هذه الآية و ما يتلوها إلى تمام تسع آيات و إن كانت مسوقة للإشارة إلى إجمال قصص قوم نوح و عاد و ثمود و فرعون و من قبله و المؤتفكات و إهلاكهم لكنّها في الحقيقة بيان للحاقّه ببعض أوصافها و هو أنّ الله أهلك أمماً كثيرة بالتكذيب بها فهي في الحقيقة جواب للسؤال بما الاستفهاميّة كما أنّ قوله:( فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ ) إلخ، جواب آخر.
و محصّل المعنى: هي القارعة الّتي كذّبت بها ثمود و عاد و فرعون و من قبله و المؤتفكات و قوم نوح فأخذهم الله أخذة رابية و أهلكهم بعذاب الاستئصال.
قوله تعالى: ( فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ) بيان تفصيليّ لأثر تكذيبهم بالقارعة، و المراد بالطاغية الصيحة أو الرجفة أو الصاعقة على اختلاف ظاهر تعبير
القرآن في سبب هلاكهم في قصّتهم قال تعالى:( وَ أَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ ) هود: 67، و قال أيضاً:( فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ ) الأعراف: 87، و قال أيضاً:( فَأَخَذَتْهُمْ صاعِقَةُ الْعَذابِ الْهُونِ ) حم السجدة: 17.
و قيل: الطاغية مصدر كالطغيان و الطغوى و المعنى: فأمّا ثمود فاُهلكوا بسبب طغيانهم، و يؤيّده قوله تعالى:( كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْواها ) الشمس: 11.
و أوّل الوجهين أنسب لسياق الآيات التالية حيث سيقت لبيان كيفيّة إهلاكهم من الإهلاك بالريح أو الأخذ الرابي أو طغيان الماء فليكن هلاك ثمود بالطاغية ناظراً إلى كيفيّة إهلاكهم.
قوله تعالى: ( وَ أَمَّا عادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عاتِيَةٍ ) الصرصر الريح الباردة الشديدة الهبوب، و عاتية من العتوّ بمعنى الطغيان و الابتعاد من الطاعة و الملاءمة.
قوله تعالى: ( سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَ ثَمانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيها صَرْعى كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ خاوِيَةٍ ) تسخيرها عليهم تسليطها عليهم، و الحسوم جمع حاسم كشهود جمع شاهد من الحسم بمعنى تكرار الكيّ مرّات متتالية، و هي صفة لسبع أي سبع ليال و ثمانية أيّام متتالية متتابعة و صرعى جمع صريع و أعجاز جمع عجز بالفتح فالضمّ آخر الشيء، و خاوية الخالية الجوف الملقاة و المعنى ظاهر.
قوله تعالى: ( فَهَلْ تَرى لَهُمْ مِنْ باقِيَةٍ ) أي من نفس باقية، و الجملة كناية عن استيعاب الهلاك لهم جميعاً، و قيل: الباقية مصدر بمعنى البقاء و قد اُريد به البقيّة و ما قدّمناه من المعنى أقرب.
قوله تعالى: ( وَ جاءَ فِرْعَوْنُ وَ مَنْ قَبْلَهُ وَ الْمُؤْتَفِكاتُ بِالْخاطِئَةِ ) المراد بفرعون فرعون موسى، و بمن قبله الاُمم المتقدّمة عليه زماناً من المكذّبين، و بالمؤتفكات قرى قوم لوط و الجماعة القاطنة بها، و( خاطئة ) مصدر بمعنى الخطاء و المراد بالمجيء بالخاطئة إخطاء طريق العبوديّة، و الباقي ظاهر.
قوله تعالى: ( فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رابِيَةً ) ضمير( فَعَصَوْا ) لفرعون و من قبله و المؤتفكات، و المراد بالرسول جنسه، و الرابية الزائدة من ربا يربو ربوة إذا زاد، و المراد بالأخذة الرابية العقوبة الشديدة و قيل: العقوبة الزائدة على سائر العقوبات و قيل: الخارقة للعادة.
قوله تعالى: ( إِنَّا لَمَّا طَغَى الْماءُ حَمَلْناكُمْ فِي الْجارِيَةِ ) إشارة إلى طوفان نوح و الجارية السفينة، و عدّ المخاطبين محمولين في سفينة نوح و المحمول في الحقيقة أسلافهم لكون الجميع نوعاً واحداً ينسب حال البعض منه إلى الكلّ و الباقي ظاهر.
قوله تعالى: ( لِنَجْعَلَها لَكُمْ تَذْكِرَةً وَ تَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ ) تعليل لحملهم في السفينة فضمير( لِنَجْعَلَها ) للحمل باعتبار أنّه فعله أي فعلنا بكم تلك الفعلة لنجعلها لكم أمراً تتذكّرون به و عبرة تعتبرون بها و موعظة تتّعظون بها.
و قوله:( وَ تَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ ) الوعي جعل الشيء في الوعاء، و المراد بوعي الاُذن لها تقريرها في النفس و حفظها فيها لترتّب عليها فائدتها و هي التذكّر و الاتّعاظ.
و في الآية بجملتيها إشارة إلى الهداية الربوبيّة بكلا قسميها أعني الهداية بمعنى إراءة الطريق و الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب.
توضيح ذلك أنّ من السنّة الربوبيّة العامّة الجارية في الكون هداية كلّ نوع من أنواع الخليقة إلى كماله اللّائق به بحسب وجوده الخاصّ بتجهيزه بما يسوقه نحو غايته كما يدلّ عليه قوله تعالى:( الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى ) طه: 50، و قوله:( الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدى ) الأعلى: 3، و قد تقدّم توضيح ذلك في تفسير سورتي طه و الأعلى و غيرهما.
و الإنسان يشارك سائر الأنواع المادّيّة في أنّ له استكمالاً تكوينيّاً و سلوكاً وجوديّاً نحو كماله الوجوديّ بالهداية الربوبيّة الّتي تسوقه نحو غايته المطلوبة و يختصّ من بينها بالاستكمال التشريعيّ فإنّ للنفس الإنسانيّة استكمالاً من
طريق أفعالها الاختياريّة بما يلحقها من الأوصاف و النعوت و تتلبّس به من الملكات و الأحوال في الحياة الدنيا و هي غاية وجود الإنسان الّتي تعيش بها عيشة سعيدة مؤبّدة.
و هذا هو السبب الداعي إلى تشريع السنّة الدينيّة بإرسال الرسل و إنزال الكتب و الهداية إليها( لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ) النساء: 165، و قد تقدّم تفصيله في أبحاث النبوّة في الجزء الثاني من الكتاب و غيره، و هذه هداية بمعنى إراءة الطريق و إعلام الصراط المستقيم الّذي لا يسع الإنسان إلّا أن يسلكه، قال تعالى:( إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً ) الدهر: 3، فإن لزم الصراط و سلكه حيّ بحياة طيّبة سعيدة و إن تركه و أعرض عنه هلك بشقاء دائم و تمّت عليه الحجّة على أيّ حال، قال تعالى:( لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ) الأنفال: 42.
إذا تقرّر هذا تبيّن أنّ من سنّة الربوبيّة هداية الناس إلى سعادة حياتهم بإراءة الطريق الموصل إليها، و إليها الإشارة بقوله:( لِنَجْعَلَها لَكُمْ تَذْكِرَةً ) فإنّ التذكرة لا تستوجب التذكّر ممّن ذكّر بها بل ربّما أثّرت و ربّما تخلّفت.
و من سنّة الربوبيّة هداية الأشياء إلى كمالاتها بمعنى إنهائها و إيصالها إليها بتحريكها و سوقها نحوه، و إليها الإشارة بقوله:( وَ تَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ ) فإنّ الوعي المذكور من مصاديق الاهتداء بالهداية الربوبيّة و إنّما لم ينسب تعالى الوعي إلى نفسه كما نسب التذكرة إلى نفسه لأنّ المطلوب بالتذكرة إتمام الحجّة و هو من الله و أمّا الوعي فإنّه و إن كان منسوباً إليه كما أنّه منسوب إلى الإنسان لكنّ السياق سياق الدعوة و بيان الأجر و المثوبة على إجابة الدعوة و الأجر و المثوبة من آثار الوعي بما أنّه فعل للإنسان منسوب إليه لا بما أنّه منسوب إلى الله تعالى.
و يظهر من الآية الكريمة أنّ للحوادث الخارجيّة تأثيراً في أعمال الإنسان كما يظهر من مثل قوله:( وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ
السَّماءِ وَ الْأَرْضِ ) الأعراف: 96 أنّ لأعمال الإنسان تأثيراً في الحوادث الخارجيّة و قد تقدّم بعض الكلام فيه.
( بحث روائي)
في الدرّ المنثور، أخرج ابن المنذر عن ابن جريح في قوله:( لِنَجْعَلَها لَكُمْ تَذْكِرَةً ) قال: لاُمّة محمّدصلىاللهعليهوآلهوسلم ، و كم من سفينة قد هلكت و أثر قد ذهب يعني ما بقي من السفينة حتى أدركته اُمّة محمّدصلىاللهعليهوآلهوسلم فرأوه كانت ألواحها ترى على الجوديّ.
أقول: و تقدّم ما يؤيّد ذلك في قصّة نوح في تفسير سورة هود.
و فيه، أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن مردويه عن مكحول قال: لمّا نزلت( وَ تَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ ) قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : سألت ربّي أن يجعلها اُذن عليّ. قال مكحول: فكان عليّ يقول: ما سمعت عن رسول الله شيئاً فنسيته.
و فيه، أخرج ابن جرير و ابن أبي حاتم و الواحديّ و ابن مردويه و ابن عساكر و ابن النجاري عن بردة قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم لعليّ: إنّ الله أمرني أن اُدنيك و لا اُقصيك و أن اُعلّمك و أن تعي و حقّ لك أن تعي فنزلت هذه الآية( وَ تَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ ) .
و فيه، أخرج أبونعيم في الحلية عن عليّ قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : يا عليّ إنّ الله أمرني أن اُدنيك و اُعلّمك لتعي فاُنزلت هذه الآية( وَ تَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ ) فأنت اُذن واعية لعلمي.
أقول: و روي هذا المعنى في تفسير البرهان، عن سعد بن عبدالله بإسناده عن أبي عبداللهعليهالسلام ، و عن الكلينيّ بإسناده عنهعليهالسلام ، و عن ابن بابويه بإسناده عن جابر عن أبي جعفرعليهالسلام .
و رواه أيضاً عن ابن شهرآشوب عن حلية الأولياء عن عمر بن عليّ، و عن الواحديّ في أسباب النزول عن بريدة، و عن أبي القاسم بن حبيب في تفسيره عن زرّ بن حبيش عن عليّعليهالسلام .
و قد روي في غاية المرام، من طرق الفريقين ستّة عشر حديثاً في ذلك و قال في البرهان إنّ محمّد بن العبّاس روى فيه ثلاثين حديثاً من طرق العامّة و الخاصّة.
( سورة الحاقّة الآيات 13 - 37)
فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ( 13 ) وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ( 14 ) فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ( 15 ) وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ( 16 ) وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا هَا هَا هَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ( 17 ) يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ ( 18 ) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ( 19 ) إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ ( 20 ) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ( 21 ) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ( 22 ) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ( 23 ) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ( 24 ) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ ( 25 ) وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ( 26 ) يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ( 27 ) مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ ( 28 ) هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ ( 29 ) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ( 30 ) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ( 31 ) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ( 32 ) إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيمِ ( 33 ) وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ( 34 ) فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ( 35 ) وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ( 36 ) لَّا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ( 37 )
( بيان)
هذا هو الفصل الثاني من الآيات يعرّف الحاقّة ببعض أشراطها و نبذة ممّا يقع فيها.
قوله تعالى: ( فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ ) قد تقدّم أنّ النفخ في الصور كناية عن البعث و الإحضار لفصل القضاء، و في توصيف النفخة بالواحدة إشارة إلى مضيّ الأمر و نفوذ القدرة فلا وهن فيه حتّى يحتاج إلى تكرار النفخة، و الّذي يسبق إلى الفهم من سياق الآيات أنّها النفخة الثانية الّتي تحيي الموتى.
قوله تعالى: ( وَ حُمِلَتِ الْأَرْضُ وَ الْجِبالُ فَدُكَّتا دَكَّةً واحِدَةً ) الدكّ أشدّ الدقّ و هو كسر الشيء و تبديله إلى أجزاء صغار، و حمل الأرض و الجبال إحاطة القدرة بها، و توصيف الدكّة بالواحدة للإشارة إلى سرعة تفتّتهما بحيث لا يفتقر إلى دكّة ثانية.
قوله تعالى: ( فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْواقِعَةُ ) أي قامت القيامة.
قوله تعالى: ( وَ انْشَقَّتِ السَّماءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ واهِيَةٌ ) انشقاق الشيء انفصال شطر منه من شطر آخر، و واهية من الوهي بمعنى الضعف، و قيل: من الوهي بمعنى شقّ الأديم و الثوب و نحوهما.
و يمكن أن تكون الآية أعني قوله:( وَ انْشَقَّتِ السَّماءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ واهِيَةٌ وَ الْمَلَكُ عَلى أَرْجائِها ) في معنى قوله:( وَ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ وَ نُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزِيلًا ) الفرقان: 25.
قوله تعالى: ( وَ الْمَلَكُ عَلى أَرْجائِها وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ ) قال الراغب: رجا البئر و السماء و غيرهما جانبها و الجمع أرجاء قال تعالى:( وَ الْمَلَكُ عَلى أَرْجائِها ) انتهى، و الملك - كما قيل - يطلق على الواحد و الجمع و المراد به في
الآية الجمع.
و قوله:( وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ ) ضمير( فَوْقَهُمْ ) على ظاهر ما يقتضيه السياق للملائكة، و قيل: الضمير للخلائق.
و ظاهر كلامه أنّ للعرش اليوم حملة من الملائكة قال تعالى:( الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ) المؤمن: 7 و قد وردت الروايات أنّهم أربعة، و ظاهر الآية أعني قوله:( وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ ) أنّ الحملة يوم القيامة ثمانية و هل هم من الملائكة أو من غيرهم؟ الآية ساكتة عن ذلك و إن كان لا يخلو السياق من إشعار ما بأنّهم من الملائكة.
و من الممكن - كما تقدّمت الإشارة إليه - أن يكون الغرض من ذكر انشقاق السماء و كون الملائكة على أرجائها و كون حملة العرش يومئذ ثمانية بيان ظهور الملائكة و السماء و العرش للإنسان يومئذ، قال تعالى:( وَ تَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ) الزمر: 75.
قوله تعالى: ( يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفى مِنْكُمْ خافِيَةٌ ) الظاهر أنّ المراد به العرض على الله كما قال تعالى:( وعُرِضُوا عَلى رَبِّكَ صَفًّا ) الكهف: 48، و العرض إراءة البائع سلعته للمشتري ببسطها بين يديه، فالعرض يومئذ على الله و هو يوم القضاء إبراز ما عند الإنسان من اعتقاد و عمل إبرازاً لا يخفى معه عقيدة خافية و لا فعلة خافية و ذلك بتبدّل الغيب شهادة و السرّ علناً قال:( يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ ) الطارق: 9، و قال:( يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ لا يَخْفى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ) المؤمن: 16.
و قد تقدّم في أبحاثنا السابقة أنّ ما عدّ في كلامه تعالى من خصائص يوم القيامة كاختصاص الملك بالله، و كون الأمر له، و أن لا عاصم منه، و بروز الخلق له و عدم خفاء شيء منهم عليه و غير ذلك، كلّ ذلك دائميّة الثبوت له تعالى، و إنّما المراد ظهور هذه الحقائق يومئذ ظهوراً لا ستر عليه و لا مرية فيه.
فالمعنى: يومئذ يظهر أنّكم في معرض على علم الله و يظهر كلّ فعلة خافية من أفعالكم.
قوله تعالى: ( فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ ) قال في المجمع، هاؤم أمر للجماعة بمنزلة هاكم، تقول للواحد: هاء يا رجل، و للاثنين: هاؤما يا رجلان، و للجماعة: هاؤم يا رجال، و للمرأة: هاء يا امرأة بكسر الهمزة و ليس بعدها ياء، و للمرأتين: هاؤما، و للنساء: هاؤنّ. هذه لغة أهل الحجاز.
و تميم و قيس يقولون: هاء يا رجل مثل قول أهل الحجاز، و للاثنين: هاءا، و للجماعة: هاؤا، و للمرأة: هائي، و للنساء هاؤنّ.
و بعض العرب يجعل مكان الهمزة كافاً فيقول: هاك هاكما هاكم هاك هاكما هاكنّ، و معناه: خذ و تناول، و يؤمر بها و لا ينهى. انتهى.
و الآية و ما بعدها إلى قوله:( الْخاطِؤُنَ ) بيان تفصيليّ لاختلاف حال الناس يومئذ من حيث السعادة و الشقاء، و قد تقدّم في تفسير قوله تعالى:( فَمَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ ) إسراء: 71 كلام في معنى إعطاء الكتاب باليمين، و الظاهر أنّ قوله:( هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ ) خطاب للملائكة، و الهاء في( كِتابِيَهْ ) و كذا في أواخر الآيات التالية للوقف و تسمّى هاء الاستراحة.
و المعنى: فأمّا من اُوتي كتابه بيمينه فيقول للملائكة: خذوا و اقرأوا كتابيه أي إنّها كتاب يقضي بسعادتي.
قوله تعالى: ( إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسابِيَهْ ) الظنّ بمعنى اليقين، و الآية تعليل لما يتحصّل من الآية السابقة و محصّل التعليل إنّما كان كتابي كتاب اليمين و قاضياً بسعادتي لأنّي أيقنت في الدنيا أنّي ساُلاقي حسابي فآمنت بربّي و أصلحت عملي.
قوله تعالى: ( فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ ) أي يعيش عيشة يرضاها فنسبة الرضا إلى العيشة من المجاز العقليّ.
قوله تعالى: ( فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ - إلى قوله -الْخالِيَةِ ) أي هو في جنّة عالية قدراً فيها ما لا عين رأت و لا اُذن سمعت و لا خطر على قلب بشر.
و قوله:( قُطُوفُها دانِيَةٌ ) القطوف جمع قطف بالكسر فالسكون و هو ما يجتنى من الثمر و المعنى: أثمارها قريبة منه يتناوله كيف يشاء.
و قوله:( كُلُوا وَ اشْرَبُوا هَنِيئاً بِما أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخالِيَةِ ) أي يقال لهم: كلوا و اشربوا من جميع ما يؤكل فيها و ما يشرب حال كونه هنيئاً لكم بما قدّمتم من الإيمان و العمل الصالح في الدنيا الّتي تقضّت أيّامها.
قوله تعالى: ( وَ أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِشِمالِهِ فَيَقُولُ يا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتابِيَهْ وَ لَمْ أَدْرِ ما حِسابِيَهْ ) و هؤلاء هم الطائفة الثانية و هم الأشقياء المجرمون يؤتون صحيفة أعمالهم بشمالهم و قد مرّ الكلام في معناه في سورة الإسراء، و هؤلاء يتمنّون أن لو لم يكونوا يؤتون كتابهم و يدرون ما حسابهم يتمنّون ذلك لما يشاهدون من أليم العذاب المعدّ لهم.
قوله تعالى: ( يا لَيْتَها كانَتِ الْقاضِيَةَ ) ذكروا أنّ ضمير( لَيْتَها ) للموتة الاُولى الّتي ذاقها الإنسان في الدنيا.
و المعنى: يا ليت الموتة الاُولى الّتي ذقتها كانت قاضية عليّ تقضي بعدمي فكنت انعدمت و لم اُبعث حيّاً فأقع في ورطة العذاب الخالد و اُشاهد ما اُشاهد.
قوله تعالى: ( ما أَغْنى عَنِّي مالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطانِيَهْ ) كلمتا تحسّر يقولهما حيث يرى خيبة سعيه في الدنيا فإنّه كان يحسب أنّ مفتاح سعادته في الحياة هو المال و السلطان يدفعان عنه كلّ مكروه و يسلّطانه على كلّ ما يحبّ و يرضى فبذل كلّ جهده في تحصيلهما و أعرض عن ربّه و عن كلّ حقّ يدعى إليه و كذّب داعيه فلمّا شاهد تقطّع الأسباب و أنّه في يوم لا ينفع فيه مال و لا بنون ذكر عدم نفع ماله و بطلان سلطانه تحسّراً و توجّعاً و ما ذا ينفع التحسّر.؟
قوله تعالى: ( خُذُوهُ فَغُلُّوهُ - إلى قوله -فَاسْلُكُوهُ ) حكاية أمره تعالى الملائكة بأخذه و إدخاله النار، و التقدير يقال للملائكة خذوه إلخ، و( فَغُلُّوهُ ) أمر من الغلّ بالفتح
و هو الشدّ بالغلّ الّذي يجمع بين اليد و الرجل و العنق.
و قوله:( ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ) أي أدخلوه النار العظيمة و ألزموه إيّاها.
و قوله:( ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً فَاسْلُكُوهُ ) السلسلة القيد، و الذرع الطول، و الذراع بُعد ما بين المرفق و رأس الأصابع و هو واحد الطول و سلوكه فيه جعله فيه، و المحصّل ثمّ اجعلوه في قيد طوله سبعون ذراعاً.
قوله تعالى: ( إِنَّهُ كانَ لا يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَ لا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ ) الحضّ التحريض و الترغيب، و الآيتان في مقام التعليل للأمر بالأخذ و الإدخال في النار أي إنّ الأخذ ثمّ التصلية في الجحيم و السلوك في السلسلة لأجل أنّه كان لا يؤمن بالله العظيم و لا يحرّض على طعام المسكين أي يساهل في أمر المساكين و لا يبالي بما يقاسونه.
قوله تعالى: ( فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هاهُنا حَمِيمٌ - إلى قوله -الْخاطِؤُنَ ) الحميم الصديق و الآية تفريع على قوله:( إِنَّهُ كانَ لا يُؤْمِنُ ) إلخ، و المحصّل: أنّه لمّا كان لا يؤمن بالله العظيم فليس له اليوم ههنا صديق ينفعه أي شفيع يشفع له إذ لا مغفرة لكافر فلا شفاعة.
و قوله:( وَ لا طَعامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ) الغسلين الغسالة و كأنّ المراد به ما يسيل من أبدان أهل النار من قيح و نحوه و الآية عطف على قوله في الآية السابقة:( حَمِيمٌ ) و متفرّع على قوله:( وَ لا يَحُضُّ ) إلخ، و المحصّل: أنّه لمّا كان لا يحرّض على طعام المسكين فليس له اليوم ههنا طعام إلّا من غسلين أهل النار.
و قوله:( لا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخاطِؤُنَ ) وصف لغسلين و الخاطؤن المتلبّسون بالخطيئة و الإثم.
( بحث روائي)
في الدرّ المنثور، في قوله تعالى:( وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ ) أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : يحمله اليوم أربعة و يوم القيامة ثمانية.
أقول: و في تقييد الحاملين في الآية بقوله:( يَوْمَئِذٍ ) إشعار بل ظهور في اختصاص العدد بالقيامة.
و في تفسير القمّيّ، و في حديث آخر قال: حمله ثمانية أربعة من الأوّلين و أربعة من الآخرين فأمّا الأربعة من الأوّلين فنوح و إبراهيم و موسى و عيسى، و أمّا الأربعة من الآخرين فمحمّد و عليّ و الحسن و الحسينعليهمالسلام .
أقول: و في غير واحد من الروايات أنّ الثمانية مخصوصة بيوم القيامة، و في بعضها أنّ حملة العرش - و العرش العلم - أربعة منّا و أربعة ممّن شاء الله.
و في تفسير العيّاشيّ، عن أبي بصير عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إنّه إذا كان يوم القيامة يدعى كلّ اُناس بإمامه الّذي مات في عصره فإن أثبته اُعطي كتابه بيمينه لقوله:( يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ ) فمن اُوتي كتابه بيمينه فاُولئك يقرؤن كتابهم، و اليمين إثبات الإمام لأنه كتابه يقرؤه - إلى أن قال - و من أنكر كان من أصحاب الشمال الّذين قال الله:( وَ أَصْحابُ الشِّمالِ ما أَصْحابُ الشِّمالِ فِي سَمُومٍ وَ حَمِيمٍ وَ ظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ ) إلخ.
أقول: و في عدّة من الروايات تطبيق قوله:( فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ ) إلخ، على عليّعليهالسلام ، و في بعضها عليه و على شيعته، و كذا تطبيق قوله:( وَ أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِشِمالِهِ ) إلخ، على أعدائه، و هي من الجري دون التفسير.
و في الدرّ المنثور، أخرج الحاكم و صحّحه عن أبي سعيد الخدريّ عن النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: لو أنّ دلوا من غسلين يهراق في الدنيا لأنتن بأهل الدنيا.
و فيه، أخرج البيهقيّ في شعب الإيمان عن صعصعة بن صوحان قال: جاء أعرابي
إلى عليّ بن أبي طالب فقال: كيف هذا الحرف: لا يأكله إلّا الخاطون؟ كلّ و الله يخطو. فتبسّم عليّ و قال: يا أعرابيّ( لا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخاطِؤُنَ ) قال: صدقت و الله يا أميرالمؤمنين ما كان الله ليسلم عبده.
ثمّ التفت عليّ إلى أبي الأسود فقال: إنّ الأعاجم قد دخلت في الدين كافّة فضع للناس شيئاً يستدلّون به على صلاح ألسنتهم فرسم لهم الرفع و النصب و الخفض.
و في تفسير البرهان، عن ابن بابويه في الدروع الواقية في حديث عن النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم : و لو أنّ ذراعاً من السلسلة الّتي ذكرها الله في كتابه وضع على جميع جبال الدنيا لذابت عن حرّها.
( سورة الحاقّة الآيات 38 - 52)
فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ( 38 ) وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ( 39 ) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ( 40 ) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ( 41 ) وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ( 42 ) تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ( 43 ) وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ( 44 ) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ( 45 ) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ( 46 ) فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ( 47 ) وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ( 48 ) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ ( 49 ) وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ( 50 ) وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ( 51 ) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ( 52 )
( بيان)
هذا هو الفصل الثالث من آيات السورة يؤكّد ما تقدّم من أمر الحاقّة بلسان تصديق القرآن الكريم ليثبت بذلك حقّيّة ما أنبأ به من أمر القيامة.
قوله تعالى: ( فَلا أُقْسِمُ بِما تُبْصِرُونَ وَ ما لا تُبْصِرُونَ ) ظاهر الآية أنّه إقسام بما هو مشهود لهم و ما لا يشاهدون أي الغيب و الشهادة فهو إقسام بمجموع الخليقة و لا يشمل ذاته المتعالية فإنّ من البعيد من أدب القرآن أن يجمع الخالق و الخلق في صفّ واحد و يعظّمه تعالى و ما صنع تعظيماً مشتركاً في عرض واحد.
و في الإقسام نوع تعظيم و تجليل للمقسم به و خلقه تعالى بما أنّه خلقه جليل جميل لأنّه تعالى جميل لا يصدر منه إلّا الجميل و قد استحسن تعالى فعل نفسه و أثنى
على نفسه بخلقه في قوله:( الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ) الم السجدة: 7، و قوله:( فَتَبارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ ) المؤمنون: 14 فليس للموجودات منه تعالى إلّا الحسن و ما دون ذلك من مساءة فمن أنفسها و بقياس بعضها إلى بعض.
و في اختيار ما يبصرون و ما لا يبصرون للأقسام به على حقّيّة القرآن ما لا يخفى من المناسبة فإنّ النظام الواحد المتشابك أجزاؤه الجاري في مجموع العالم يقضي بتوحّده تعالى و مصير الكلّ إليه و ما يترتّب عليه من بعث الرسل و إنزال الكتب و القرآن خير كتاب سماويّ يهدي إلى الحقّ في جميع ذلك و إلى طريق مستقيم.
و ممّا تقدّم يظهر عدم استقامة ما قيل: إنّ المراد بما تبصرون و ما لا تبصرون الخلق و الخالق فإنّ السياق لا يساعد عليه، و كذا ما قيل: إنّ المراد النعم الظاهرة و الباطنة، و ما قيل: إنّ المراد الجنّ و الإنس و الملائكة أو الأجسام و الأرواح أو الدنيا و الآخرة أو ما يشاهد من آثار القدرة و ما لا يشاهد من أسرارها فاللفظ أعمّ مدلولاً من جميع ذلك.
قوله تعالى: ( إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ) الضمير للقرآن، و المستفاد من السياق أنّ المراد برسول كريم النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم و هو تصديق لرسالته قبال ما كانوا يقولون إنّه شاعر أو كاهن.
و لا ضير في نسبة القرآن إلى قوله فإنّه إنّما ينسب إليه بما أنّه رسول و الرسول بما أنّه رسول لا يأتي إلّا بقول مرسلة، و قد بيّن ذلك فضل بيان بقوله بعد:( تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ ) .
و قيل: المراد برسول كريم جبريل، و السياق لا يؤيّده إذ لو كان هو المراد لكان الأنسب نفي كونه ممّا نزلت به الشياطين كما فعل في سورة الشعراء.
على أنّ قوله بعد:( وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ ) و ما يتلوه إنّما يناسب كونهصلىاللهعليهوآلهوسلم هو المراد برسول كريم.
قوله تعالى: ( وَ ما هُوَ بِقَوْلِ شاعِرٍ قَلِيلًا ما تُؤْمِنُونَ ) نفي أن يكون القرآن
نظماً ألّفه شاعر و لم يقل النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم شعراً و لم يكن شاعراً.
و قوله:( قَلِيلًا ما تُؤْمِنُونَ ) توبيخ لمجتمعهم حيث إنّ الأكثرين منهم لم يؤمنوا و ما آمن به إلّا قليل منهم.
قوله تعالى: ( وَ لا بِقَوْلِ كاهِنٍ قَلِيلًا ما تَذَكَّرُونَ ) نفي أن يكون القرآن كهانة و النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم كاهنا يأخذ القرآن من الجنّ و هم يُلقونه إليه.
و قوله:( قَلِيلًا ما تَذَكَّرُونَ ) توبيخ أيضاً لمجتمعهم.
قوله تعالى: ( تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ ) أي منزل من ربّ العالمين و ليس من صنع الرسول نسبه إلى الله كما تقدّمت الإشارة إليه.
قوله تعالى: ( وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ - إلى قوله -حاجِزِينَ ) يقال: تقوّل على فلان أي اختلق قولاً من نفسه و نسبه إليه، و الوتين - على ما ذكره الراغب - عرق يسقي الكبد و إذا انقطع مات صاحبه، و قيل: هو رباط القلب.
و المعنى:( وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا ) هذا الرسول الكريم الّذي حمّلناه رسالتنا و أرسلناه إليكم بقرآن نزّلناه عليه و اختلق( بَعْضَ الْأَقاوِيلِ ) و نسبه إلينا( لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ) كما يقبض على المجرم فيؤخذ بيده أو المراد قطعنا منه يده اليمنى أو المراد لانتقمنا منه بالقوّة كما في رواية القمّيّ( ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ ) و قتلناه لتقوّله علينا( فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ ) تحجبونه عنّا و تنجونه من عقوبتنا و إهلاكنا.
و هذا تهديد للنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم على تقدير أن يفتري على الله كذباً و ينسب إليه شيئاً لم يقله و هو رسول من عنده أكرمه بنبوّته و اختاره لرسالته.
فالآيات في معنى قوله:( لَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلًا إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ وَ ضِعْفَ الْمَماتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنا نَصِيراً ) إسراء: 75، و كذا قوله في الأنبياء بعد ذكر نعمه العظمى عليهم:( وَ لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ ) الأنعام: 88.
فلا يرد أنّ مقتضى الآيات أنّ كلّ من ادّعى النبوّة و افترى على الله الكذب أهلكه الله و عاقبه في الدنيا أشدّ العقاب و هو منقوض ببعض مدّعي النبوّة من الكذّابين.
و ذلك أنّ التهديد في الآية متوجّه إلى الرسول الصادق في رسالته لو تقوّل على الله و نسب إليه بعض ما ليس منه لا مطلق مدّعي النبوّة المفتري على الله في دعواه النبوّة و إخباره عن الله تعالى.
قوله تعالى: ( وَ إِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ) يذكّرهم كرامة تقواهم و معارف المبدأ و المعاد بحقائقها، و يعرّفهم درجاتهم عند الله و مقاماتهم في الآخرة و الجنّة و ما هذا شأنه لا يكون تقوّلاً و افتراء فالآية مسوقة حجّة على كون القرآن منزّهاً عن التقوّل و الفرية.
قوله تعالى: ( وَ إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَ إِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكافِرِينَ ) ستظهر لهم يوم الحسرة.
قوله تعالى: ( وَ إِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ) قد تقدّم كلام في نظيرتي الآيتين في آخر سورة الواقعة، و السورتان متّحدتان في الغرض و هو وصف يوم القيامة و متّحدتان في سياق خاتمتهما و هي الإقسام على حقّيّة القرآن المنبئ عن يوم القيامة، و قد ختمت السورتان بكون القرآن و ما أنبأ به عن وقوع الواقعة حقّ اليقين ثمّ الأمر بتسبيح اسم الربّ العظيم المنزّه عن خلق العالم باطلاً لا معاد فيه و عن أن يبطل المعارف الحقّة الّتي يعطيها القرآن في أمر المبدأ و المعاد.
( سورة المعارج مكّيّة و هي أربع و أربعون آية)
( سورة المعارج الآيات 1 - 18)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ( 1 ) لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ( 2 ) مِّنَ اللهِ ذِي الْمَعَارِجِ ( 3 ) تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ( 4 ) فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ( 5 ) إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ( 6 ) وَنَرَاهُ قَرِيبًا ( 7 ) يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ( 8 ) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ( 9 ) وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ( 10 ) يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ( 11 ) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ( 12 ) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ( 13 ) وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ( 14 ) كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ ( 15 ) نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ ( 16 ) تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ( 17 ) وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ( 18 )
( بيان)
الّذي يعطيه سياق السورة أنّها تصف يوم القيامة بما اُعدّ فيه من أليم العذاب للكافرين. تبتدئ السورة فتذكر سؤال سائل سأل عذاباً من الله للكافرين فتشير إلى أنّه واقع ليس له دافع قريب غير بعيد كما يحسبونه ثمّ تصف اليوم الّذي يقع فيه و العذاب الّذي اُعدّ لهم فيه و تستثني المؤمنين الّذين قاموا بوظائف الاعتقاد الحقّ و العمل الصالح.
و هذا السياق يشبه سياق السور المكّيّة غير أنّ المنقول عن بعضهم أنّ قوله:( وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ) مدني و الاعتبار يؤيّده لأنّ ظاهره الزكاة و قد شرّعت بالمدينة بعد الهجرة، و كون هذه الآية مدنيّة يستتبع كون الآيات الحافّة بها الواقعة تحت الاستثناء و هي أربع عشرة آية (قوله:إِلَّا الْمُصَلِّينَ - إلى قوله -فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ) مدنيّة لما في سياقها من الاتّحاد و استلزام البعض للبعض.
و مدنيّة هذه الآيات الواقعة تحت الاستثناء تستدعي ما استثنيت منه و هو على الأقل ثلاث آيات (قوله:إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً - إلى قوله -مَنُوعاً ).
على أنّ قوله:( فَما لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ) متفرّع على ما قبله تفرّعاً ظاهراً و هو ما بعده إلى آخر السورة ذو سياق واحد فتكون هذه الآيات أيضاً مدنيّة.
و من جهة اُخرى مضامين هذا الفصل من الآيات تناسب حال المنافقين الحافّين حول النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم عن اليمين و عن الشمال عزين و هم الرادّون لبعض ما أنزل الله من الحكم و خاصّة قوله:( أَ يَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ ) إلخ، و قوله:( عَلى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْراً مِنْهُمْ ) إلخ على ما سيجيء، و موطن ظهور هذا النفاق المدينة لا مكّة، و لا ضير في التعبير عن هؤلاء بالّذين كفروا فنظير ذلك موجود في سورة التوبة و غيرها.
على أنّهم رووا أنّ السورة نزلت في قول القائل:( اللهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ أَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ أَلِيمٍ ) الأنفال: 32 و قد تقدّم في تفسير الآية أنّ سياقها و الّتي بعدها سياق مدنيّ لا مكّي. لكنّ المرويّ عن الصادقعليهالسلام أنّ المراد بالحقّ المعلوم في الآية حق يسمّيه صاحب المال في ماله غير الزكاة المفروضة.
و لا عبرة بما نسب إلى اتّفاق المفسّرين أنّ السورة مكّيّة على أنّ الخلاف ظاهر و كذا ما نسب إلى ابن عبّاس أنّها نزلت بعد سورة الحاقّة.
قوله تعالى: ( سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ ) السؤال بمعنى الطلب و الدعاء، و لذا عدّي بالباء كما في قوله:( يَدْعُونَ فِيها بِكُلِّ فاكِهَةٍ آمِنِينَ ) الدخان: 55 و قيل: الفعل مضمّن معنى الاهتمام و الاعتناء و لذا عدّي بالباء، و قيل: الباء زائدة للتأكيد،
و مآل الوجوه واحد و هو طلب العذاب من الله كفراً و عتوّاً.
و قيل: الباء بمعنى عن كما في قوله:( فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً ) الفرقان: 59، و فيه أنّ كونها في الآية المستشهد بها بمعنى عن ممنوع. على أنّ سياق الآيات التالية و خاصّة قوله:( فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلًا ) لا يلائم كون السؤال بمعنى الاستفسار و الاستخبار.
فالآية تحكي سؤال العذاب و طلبه عن بعض من كفر طغياناً و كفراً، و قد وصف العذاب المسؤل من الأوصاف بما يدلّ على إجابة الدعاء بنوع من التهكّم و التحقير و هو قوله:( واقِعٍ ) و قوله:( لَيْسَ لَهُ دافِعٌ ) .
و المعنى سأل سائل من الكفّار عذاباً للكافرين من الله سيصيبهم و يقع عليهم لا محالة و لا دافع له أي إنّه واقع عليهم سأل أو لم يسأل ففيه جواب تحقيريّ و إجابة لمسؤله تهكّماً.
قوله تعالى: ( لِلْكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ ) للكافرين متعلّق بعذاب و صفة له، و كذا قوله:( لَيْسَ لَهُ دافِعٌ ) و قد مرّت الإشارة إلى معنى الآية.
قوله تعالى: ( مِنَ اللهِ ذِي الْمَعارِجِ ) الجارّ و المجرور متعلّق بقوله:( دافِعٌ ) أي ليس له دافع من جانب الله و من المعلوم أنّه لو اندفع لم يندفع إلّا من جانب الله سبحانه، و من المحتمل أن يتعلّق بقوله:( بِعَذابٍ ) .
و المعارج جمع معرج و فسّروه بالمصاعد و هي الدرجات و هي مقامات الملكوت الّتي يعرج إليها الملائكة عند رجوعهم إلى الله سبحانه على ما يفسّره قوله بعد:( تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ ) إلخ فله سبحانه معارج الملكوت و مقاماتها المترتّبة علوّاً و شرفاً الّتي تعرج فيها الملائكة و الروح بحسب قربهم من الله و ليست بمقامات وهميّة اعتباريّة.
و قيل: المراد بالمعارج الدرجات الّتي يصعد فيها الاعتقاد الحقّ و العمل الصالح قال تعالى:( إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ) الفاطر 10، و قال:( وَ لكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ ) الحجّ: 37.
و قيل: المراد به مقامات القرب الّتي يعرج إليها المؤمنون بالإيمان و العمل
الصالح قال تعالى:( هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللهِ وَ اللهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ ) آل عمران: 163 و قال:( لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ ) الأنفال: 4 و قال:( رَفِيعُ الدَّرَجاتِ ذُو الْعَرْشِ ) المؤمن: 15.
و الحقّ أنّ مآل الوجهين إلى الوجه الأوّل، و الدرجات المذكورة حقيقيّة ليست بالوهميّة الاعتباريّة.
قوله تعالى: ( تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ) المراد بهذا اليوم يوم القيامة على ما يفيده سياق الآيات التالية.
و المراد بكون مقدار هذا اليوم خمسين ألف سنة على ما ذكروا أنّه بحيث لو وقع في الدنيا و انطبق على الزمان الجاري فيها كان مقداره من الزمان خمسين ألف سنة من سني الدنيا.
و المراد بعروج الملائكة و الروح إليه يومئذ رجوعهم إليه تعالى عند رجوع الكلّ إليه فإنّ يوم القيامة يوم بروز سقوط الوسائط و تقطّع الأسباب و ارتفاع الروابط بينها و بين مسبّباتها و الملائكة وسائط موكّلة على اُمور العالم و حوادث الكون فإذا تقطّعت الأسباب عن مسبّباتها و زيّل الله بينهم و رجع الكلّ إلى الله عزّ اسمه رجعوا إليه و عرجوا معارجهم فحفّوا من حول عرش ربّهم و صفّوا قال تعالى:( وَ تَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ ) الزمر 75، و قال:( يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلائِكَةُ صَفًّا ) النبأ: 38.
و الظاهر أنّ المراد بالروح الروح الّذي هو من أمره تعالى كما قال:( قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ) إسراء: 85 و هو غير الملائكة كما هو ظاهر قوله تعالى:( يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ ) النحل: 2.
فلا يعبأ بما قيل: إنّ المراد بالروح جبرئيل و إن اُطلق عليه الروح الأمين و روح القدس في قوله:( نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلى قَلْبِكَ ) الشعراء: 194 و قوله:( قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ ) النحل: 103 فإنّ المقيّد غير المطلق.
قوله تعالى: ( فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلًا ) لمّا كان سؤال السائل للعذاب عن تعنّت
و استكبار و هو ممّا يشقّ تحمّله أمر نبيّهصلىاللهعليهوآلهوسلم بالصبر و وصفه بالجميل - و الجميل من الصبر ما ليس فيه شائبة الجزع و الشكوى - و علّله بأنّ اليوم بما فيه من العذاب قريب.
قوله تعالى: ( إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَ نَراهُ قَرِيباً ) ضميراً( يَرَوْنَهُ ) و( نَراهُ ) للعذاب أو ليوم القيامة بما فيه من العذاب الواقع و يؤيّد الأوّل قوله فيما بعد:( يَوْمَ تَكُونُ السَّماءُ كَالْمُهْلِ ) إلخ.
و المراد بالرؤية الاعتقاد بنوع من العناية المجازيّة و رؤيتهم ذلك بعيداً ظنّهم أنّه بعيد من الإمكان فإنّ سؤال العذاب من الله سبحانه استكباراً عن دينه و ردّاً لحكمه لا يجامع الإيمان بالمعاد و إن تفوّه به السائل، و رؤيته تعالى ذلك قريباً علمه بتحقّقه و كلّ ما هو آت قريب.
و في الآيتين تعليل أمرهصلىاللهعليهوآلهوسلم بالصبر الجميل فإنّ تحمّل الأذى و الصبر على المكاره يهون على الإنسان إذا استيقن أنّ الفرج قريب و تذكّر ذلك فالكلام في معنى قولنا فاصبر على تعنّتهم و استكبارهم في سؤالهم العذاب صبراً جميلاً لا يشوبه جزع و شكوى فإنّا نعلم أنّ العذاب قريب على خلاف ما يستبعدونه، و علمنا لا يتخلّف عن الواقع بل هو نفس الواقع.
قوله تعالى: ( يَوْمَ تَكُونُ السَّماءُ كَالْمُهْلِ ) المهل المذاب من المعدنيّات كالنحاس و الذهب و غيرهما، و قيل: درديّ الزيت، و قيل: عكر القطران(1) .
و الظرف متعلّق بقوله:( واقِعٍ ) على ما يفيده السياق.
قوله تعالى: ( وَ تَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ ) العهن مطلق الصوف، و لعلّ المراد المنفوش منه كما في قوله تعالى:( وَ تَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ) القارعة: 5.
و قيل: هو الصوف الأحمر، و قيل: المصبوغ ألواناً لأنّ الجبال ذات ألوان مختلفة فمنها جدد بيض و حمر و غرابيب سود(2) .
____________________
(1) أي ردية و خبيثه.
(2) كما في الآية من سورة فاطر.
قوله تعالى: ( وَ لا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً ) الحميم القريب الّذي تهتمّ بأمره و تشفق عليه.
إشارة إلى شدّة اليوم فالإنسان يومئذ تشغله نفسه عن غيره حتّى أنّ الحميم لا يسأل حميمه عن حاله لاشتغاله بنفسه.
قوله تعالى: ( يُبَصَّرُونَهُمْ ) الضميران للأحماء المعلوم من السياق و التبصير الإراءة و الإيضاح أي يُرى و يوضح الأحماء للأحماء فلا يسألونهم عن حالهم اشتغالاً بأنفسهم.
و الجملة مستأنفة في معنى الجواب عن سؤال مقدّر كأنّه لمّا قيل: لا يسأل حميم حميماً سئل فقيل: هل يرى الأحماء يومئذ أحماءهم؟ فاُجيب: يبصّرونهم و يمكن أن يكون( يُبَصَّرُونَهُمْ ) صفة( حَمِيماً ) .
و من رديءً التفسير قول بعضهم: إنّ معنى قوله:( يُبَصَّرُونَهُمْ ) يبصّر الملائكة الكفّار، و ما قيل: إنّ المعنى يبصّر المؤمنون أعداءهم من الكفّار و ما هم فيه من العذاب فيشمتون بهم، و ما قيل: إنّ المعنى يبصّر أتباع الضلالة رؤساءهم. و هي جميعاً وجوه لا دليل عليها.
قوله تعالى: ( يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَ صاحِبَتِهِ وَ أَخِيهِ وَ فَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنْجِيهِ ) قال في المجمع: المودّة مشتركة بين التمنّي و بين المحبّة يقال: وددت الشيء أي تمنّيته و وددته أي أحببته أودّ فيهما جميعاً. انتهى، و يمكن أن يكون استعماله بمعنى التمنّي من باب التضمين.
و قال: و الافتداء الضرر عن الشيء ببدل منه انتهى، و قال: الفصيلة الجماعة المنقطعة عن جملة القبيلة برجوعها إلى اُبوّة خاصّة عن اُبوّة عامّة. انتهى، و ذكر بعضهم أنّ الفصيلة عشيرته الأقربين الّذين فصل عنهم كالآباء الأدنين.
و سياق هذه الآيات سياق الإضراب و الترقّي بالنسبة إلى قوله:( وَ لا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً ) فيفيد أنّ المجرم يبلغ به شدّة العذاب إلى أن يتمنّى أن يفتدي من العذاب بأحبّ أقاربه و أكرمهم عليه بنيه و صاحبته و أخيه و فصيلته و جميع من في الأرض ثمّ ينجيه الافتداء فيودّ ذلك فضلاً عن عدم سؤاله عن حال حميمه.
و المعنى( يَوَدُّ ) و يتمنّى( الْمُجْرِمُ ) و هو المتلبّس بالأجرام أعمّ من الكافر( لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذابِ يَوْمِئِذٍ ) و هذا هو الّذي يتمنّاه، و الجملة قائمة مقام مفعول يودّ.( بِبَنِيهِ ) الّذين هم أحبّ الناس عنده( وَ صاحِبَتِهِ ) الّتي كانت سكنا له و كان يحبّها و ربّما قدّمها على أبويه( وَ أَخِيهِ ) الّذي كان شقيقه و ناصره( وَ فَصِيلَتِهِ ) من عشيرته الأقربين( الَّتِي تُؤْوِيهِ ) و تضمّه إليها( وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ) من اُولي العقل( ثُمَّ يُنْجِيهِ ) هذا الافتداء.
قوله تعالى: ( كَلَّا إِنَّها لَظى نَزَّاعَةً لِلشَّوى تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَ تَوَلَّى وَ جَمَعَ فَأَوْعى ) كلّا للردع، و ضمير( إِنَّها ) لجهنّم أو للنار و سمّيت لظى لكونها تتلظّى و تشتعل، و النزّاعة اسم مبالغة من النزع بمعنى الاقتلاع، و الشوى الأطراف كاليد و الرجل يقال: رماه فأشواه أي أصاب شواه كذا قال الراغب، و إيعاء المال إمساكه في وعاء.
فقوله:( كَلَّا ) ردع لتمنّيه النجاة من العذاب بالافتداء و قد علّل الردع بقوله:( إِنَّها لَظى ) إلخ و محصّله أنّ جهنّم نار مشتعلة محرقة للأطراف شأنها أنّها تطلب المجرمين لتعذّبهم فلا تصرف عنهم بافتداء كائناً ما كان.
فقوله:( إِنَّها لَظى ) أي نار صفتها الاشتعال لا تنعزل عن شأنها و لا تخمد، و قوله:( نَزَّاعَةً لِلشَّوى ) أي صفتها إحراق الأطراف و اقتلاعها لا يبطل ما لها من الأثر فيمن تعذّبه.
و قوله:( تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَ تَوَلَّى وَ جَمَعَ فَأَوْعى ) أي تطلب من أدبر عن الدعوة الإلهيّة إلى الإيمان بالله و أعرض عن عبادته تعالى و جمع المال فأمسكه في وعائه و لم ينفق منه للسائل و المحروم.
و هذا المعنى هو المناسب لسياق الاستثناء الآتي و ذكر الصلاة و الإنفاق فيه.
( بحث روائي)
في المجمع، حدّثنا السيّد أبوالحمد قال: حدّثنا الحاكم أبوالقاسم الحسكاني و ساق السند عن جعفر بن محمّد الصادق عن آبائهعليهمالسلام قال: لما نصب رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم عليّا و قال: من كنت مولاه فعليّ مولاه، طار ذلك في البلاد فقدم على النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم النعمان بن الحارث الفهريّ.
فقال: أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلّا الله و أنّك رسول الله و أمرتنا بالجهاد و الحجّ و الصوم و الصلاة و الزكاة فقبلناها ثمّ لم ترض حتّى نصبت هذا الغلام فقلت: من كنت مولاه فعليّ مولاه، فهذا شيء منك أو أمر من عند الله؟ فقال: و الله الّذي لا إله إلّا هو إنّ هذا من الله.
فولى النعمان بن الحارث و هو يقول: اللّهمّ إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء فرماه الله بحجر على رأسه فقتله و أنزل الله تعالى:( سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ ) .
أقول: و هذا المعنى مروي بغير طريق من طرق الشيعة، و قد ردّ الحديث بعضهم بأنّه موضوع لكون سورة المعارج مكّيّة، و قد عرفت الكلام في مكّيّة السورة.
و في الدرّ المنثور، أخرج الفاريابيّ و عبد بن حميد و النسائيّ و ابن أبي حاتم و الحاكم و صحّحه و ابن مردويه عن ابن عبّاس في قوله:( سَأَلَ سائِلٌ ) قال هو النضر بن الحارث قال: اللّهمّ إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء.
و فيه، أخرج ابن أبي حاتم عن السدّيّ: في قوله:( سَأَلَ سائِلٌ ) قال. نزلت بمكّة في النضر بن الحارث و قد قال:( اللهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ ) الآية و كان عذابه يوم بدر.
أقول: و هذا المعنى مرويّ أيضاً عن غير السدّيّ، و في بعض رواياتهم أنّ
القائل:( اللهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ ) الآية هو الحارث بن علقمة رجل من عبد الدار، و في بعضها أنّ سائل العذاب هو أبوجهل بن هشام سأله يوم بدر و لازمه مدنيّة السورة و المعتمد على أيّ حال نزول السورة بعد قول القائل:( اللهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ ) الآية و قد تقدّم كلام في سياق الآية.
و في أمالي الشيخ، بإسناده إلى أبي عبداللهعليهالسلام في حديث: ألا فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فإنّ في القيامة خمسين موقفاً كلّ موقف مثل ألف سنة ممّا تعدّون ثمّ تلا هذه الآية( فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ) .
أقول: و روي هذا المعنى في روضة الكافي، عن حفص بن غياث عنهعليهالسلام .
و في المجمع، روى أبوسعيد الخدريّ قال: قيل لرسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : ما أطول هذا اليوم فقال: و الّذي نفس محمّد بيده إنّه ليخفّ على المؤمن حتّى يكون أخفّ عليه من صلاة مكتوبة يصلّيها في الدنيا.
أقول: و رواه في الدرّ المنثور، عن عدّة من الجوامع عن أبي سعيد عنهصلىاللهعليهوآلهوسلم .
و في تفسير القمّيّ في قوله تعالى:( يَوْمَ تَكُونُ السَّماءُ كَالْمُهْلِ ) قال: الرصاص الذائب و النحاس كذلك تذوب السماء.
و فيه، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرعليهالسلام : في قوله تعالى:( يُبَصَّرُونَهُمْ ) يقول: يعرّفونهم ثمّ لا يتساءلون.
و فيه في قوله تعالى:( نَزَّاعَةً لِلشَّوى ) قال: تنزع عينه و تسودّ وجهه.
و فيه في قوله تعالى:( تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَ تَوَلَّى ) قال: تجرّه إليها.
( سورة المعارج الآيات 19 - 35)
إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ( 19 ) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ( 20 ) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ( 21 ) إِلَّا الْمُصَلِّينَ ( 22 ) الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ( 23 ) وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ( 24 ) لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ( 25 ) وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ( 26 ) وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ( 27 ) إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ( 28 ) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ( 29 ) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ( 30 ) فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ( 31 ) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ( 32 ) وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ( 33 ) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ( 34 ) أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ( 35 )
( بيان)
تشير الآيات إلى السبب الاُولي الّذي يدعو الإنسان إلى رذيلة الإدبار و التولّي و الجمع و الإيعاء الّتي تؤدّيه إلى دخول النار الخالدة الّتي هي لظى نزّاعة للشوى على ما تذكره الآيات.
و ذلك السبب صفة الهلع الّتي اقتضت الحكمة الإلهيّة أن يخلق الإنسان عليها ليهتدي بها إلى ما فيه خيره و سعادته غير أنّ الإنسان يفسدها على نفسه و يسييء
استعمالها في سبيل سعادته فتسلك به إلى هلكة دائمة إلّا الّذين آمنوا و عملوا الصالحات فهم في جنّات مكرمون.
قوله تعالى: ( إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً وَ إِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً ) الهلوع صفة مشتقّة من الهلع بفتحتين و هو شدّة الحرص، و ذكروا أيضاً أنّ الهلوع تفسّره الآيتان بعده فهو الجزوع عند الشرّ و المنوع عند الخير و هو تفسير سديد و السياق يناسبه.
و ذلك أنّ الحرص الشديد الّذي جبل عليه الإنسان ليس حرصاً منه على كلّ شيء خيراً كان أو شرّاً أو نافعاً أو ضارّاً بل حرصاً على الخير و النافع و لا حرصاً على كلّ خير أو نافع سواء ارتبط به أو لم يرتبط و كان له أو لغيره بل حرصاً منه على ما يراه خيراً لنفسه أو نافعاً في سبيل الخير، و لازم هذا الحرص أن يظهر منه التزعزع و الاضطراب عند مسّ الشرّ و هو خلاف الخير و أن يمتنع عن ترك الخير عند مسّه و يؤثر نفسه على غيره إلّا أن يرى الترك أكثر خيراً و أنفع بحاله فالجزع عند مسّ الشرّ و المنع عند مسّ الخير من لوازم الهلع و شدّة الحرص.
و ليس الهلع و شدّة الحرص المجبول عليه الإنسان - و هو من فروع حبّ الذات - في حدّ نفسه من الرذائل المذمومة كيف؟ و هي الوسيلة الوحيدة الّتي تدعو الإنسان إلى بلوغ سعادته و كمال وجوده، و إنّما تكون رذيلة مذمومة إذا أساء الإنسان في تدبيرها فاستعملها فيما ينبغي و فيما لا ينبغي و بالحقّ و بغير حقّ كسائر الصفات النفسانيّة الّتي هي كريمة ما لزمت حدّ الاعتدال و إذا انحرفت إلى جانب الإفراط أو التفريط عادت رذيلة ذميمة.
فالإنسان في بدء نشأته و هو طفل يرى ما يراه خيراً لنفسه أو شرّاً لنفسه بما جهّز به من الغرائز العاطفة و هي الّتي تهواه نفسه و تشتهيه قواه من غير أن يحدّه بحدّ أو يقدّره بقدر فيجزع إذا مسّه ألم أو أيّ مكروه، و يمنع من يزاحمه فيما أمسك به بكلّ ما يقدر عليه من بكاء و نحوه.
و هو على هذه الحال حتّى إذا رزق العقل و الرشد أدرك الحقّ و الباطل و
الخير و الشرّ و اعترفت نفسه بما أدرك و حينئذ يتبدّل عنده كثير من مصاديق الحقّ و الباطل و الخير و الشرّ فعاد كثير ممّا كان يراه خيراً لنفسه شرّاً عنده و بالعكس.
فإن أقام على ما كان عليه من اتّباع أهواء النفس و العكوف على المشتهيّات و اشتغل بها عن اتّباع الحقّ و غفل عنه، طبع على قلبه فلم يواجه حقّاً إلّا دحضه و لا ذا حقّ إلّا اضطهده و إن أدركته العناية الإلهيّة عاد ما كان عنده من الحرص على ما تهواه النفس حرصاً على الحقّ فلم يستكبر على حقّ واجهه و لا منع ذا حقّ حقّه.
فالإنسان في بادئ أمره و هو عهد الصبي قبل البلوغ و الرشد مجهّز بالحرص الشديد على الخير و هو صفة كماليّة له بحسب حاله بها ينبعث إلى جلب الخير و اتّقاء الشرّ قال تعالى:( وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ) العاديات: 8.
ثمّ إذا رزق البلوغ و الرشد زاد تجهيزاً آخر و هو العقل الّذي بها يدرك حقائق الاُمور على ما هي عليها فيدرك ما هو الاعتقاد الحقّ و ما هو الخير في العمل، و يتبدّل حرصه الشديد على الخير و كونه جزوعاً عند مسّ الشرّ و منوعاً عند مسّ الخير من الحرص الشديد على الخير الواقعي من الفزع و الخوف إذا مسّه شر اُخرويّ و هو المعصية و المسابقة إلى مغفرة ربّه إذا مسّه خير اُخرويّ و هو مواجهة الحسنة، و أمّا الشرّ و الخير الدنيويّان فإنّه لا يتعدّى فيهما ما حدّه الله له من الصبر عند المصيبة و الصبر على الطاعة و الصبر عن المعصية و هذه الصفة صفة كماليّة لهذا الإنسان.
و أمّا إذا أعرض الإنسان عمّا يدركه عقله و يعترف به فطرته و عكف على اتّباع الهوى و اعتنق الباطل و تعدّى إلى حقّ كلّ ذي حقّ و لم يقف في حرصه على الخير على حدّ فقد بدّل نعمة الله نقمة و أخذ صفة غريزيّة خلقها الله وسيلة له يتوسّل بها إلى سعادة الدنيا و الآخرة وسيلة إلى الشقوة و الهلكة تسوقه إلى الإدبار و التولّي و الجمع و الإيعاء كما في الآيات.
و قد بان ممّا تقدّم أنّه لا ضير في نسبة هلع الإنسان في الآيات إلى الخلقة و الكلام مسوق للذمّ و قد قال تعالى:( الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ) السجدة 7، و ذلك أنّ ما يلحقه من الذمّ إنّما هو من قبل الإنسان و سوء تدبيره لا من قبله تعالى فهو كسائر نعمه تعالى على الإنسان الّتي يصيّرها نقماً بسوء اختياره.
و ذكر الزمخشريّ فراراً من الإشكال أنّ في الكلام استعارة، و المعنى أنّ الإنسان لإيثاره الجزع و المنع و تمكّنهما منه كأنّه مجبول مطبوع عليهما، و كأنّه أمر مخلوق فيه ضروريّ غير اختياريّ فالكلام موضوع على التشبيه لا لإفادة كونه مخلوقاً لله حقيقة لأنّ الكلام مسوق للذمّ و الله سبحانه لا يذمّ فعل نفسه، و من الدليل عليه استثناء المؤمنين الّذين جاهدوا أنفسهم فنجوا عن الجزع و المنع جميعاً.
و فيه أنّ الصفة مخلوقة نعمة و فضيلة و الإنسان هو الّذي يخرجها من الفضيلة إلى الرذيلة و من النعمة إلى النقمة و الذمّ راجع إلى الصفة من جهة سوء تدبيره لا من حيث إنّها فعله تعالى.
و استثناء المؤمنين ليس لأجل أنّ الصفة غير مخلوقة فيهم بل لأجل أنّهم أبقوها على كمالها و لم يبدّلوها رذيلة و نقمة.
و اُجيب أيضاً عن الاستثناء بأنّه منقطع و هو كما ترى.
قوله تعالى: ( إِلَّا الْمُصَلِّينَ ) استثناء من الإنسان الموصوف بالهلع، و في تقديم الصلاة على سائر الأعمال الصالحة المعدودة في الآيات التالية دلالة على شرفها و أنّها خير الأعمال.
على أنّ لها الأثر البارز في دفع رذيلة الهلع المذموم و قد قال تعالى:( إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ ) العنكبوت: 45.
قوله تعالى: ( الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ ) في إضافة الصلاة إلى الضمير دلالة على أنّهم مداومون على ما يأتون به من الصلاة كائنة ما كانت لا أنّهم دائماً في الصلاة، و فيه إشارة إلى أنّ العمل إنّما يكمل أثره بالمداومة.
قوله تعالى: ( وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ ) فسّره بعضهم
بالزكاة المفروضة، و في الحديث عن الصادقعليهالسلام : أنّ الحقّ المعلوم ليس من الزكاة و إنّما هو مقدار معلوم ينفقونه للفقراء، و السائل هو الفقير الّذي يسأل، و المحروم الفقير الّذي يتعفّف و لا يسأل و السياق لا يخلو من تأييده فإنّ للزكاة موارد مسمّاة في قوله:( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ ) التوبة 60 و ليست مختصّة بالسائل و المحروم على ما هو ظاهر الآية.
قوله تعالى: ( وَ الَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ) الّذي يفيده سياق عدّ الأعمال الصالحة أنّ المراد بتصديقهم يوم الدين التصديق العمليّ دون التصديق الاعتقاديّ و ذلك بأن تكون سيرتهم في الحياة سيرة من يرى أنّ ما يأتي به من عمل سيحاسب عليه فيجازي به إن خيراً فخيراً و إن شرّاً فشرّاً.
و في التعبير بقوله:( يُصَدِّقُونَ ) دلالة على الاستمرار فهو المراقبة الدائمة بذكره تعالى عند كلّ عمل يواجهونه فيأتون بما يريده و يتركون ما يكرهه.
قوله تعالى: ( وَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ) أي خائفون، و الكلام في إشفاقهم من عذاب ربّهم نظير الكلام في تصديقهم بيوم الدين فهو الإشفاق العملي الظاهر من حالهم.
و لازم إشفاقهم من عذاب ربّهم مع لزومهم الأعمال الصالحة و مجاهدتهم في الله أن لا يثقوا بما يأتون به من الأعمال الصالحة و لا يأمنوا عذاب الله فإنّ الأمن لا يجامع الخوف.
و الملاك في الإشفاق من العذاب أنّ العذاب على المخالفة فلا منجى منه إلّا بالطاعة من النفس و لا ثقة بالنفس إذ لا قدرة لها في ذاتها إلّا ما أقدرها الله عليه و الله سبحانه مالك غير مملوك، قال تعالى:( قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللهِ شَيْئاً ) المائدة 17.
على أنّ الله سبحانه و إن وعد أهل الطاعة النجاة و ذكر أنّه لا يخلف الميعاد لكنّ الوعد لا يقيّد إطلاق قدرته فهو مع ذلك قادر على ما يريد و مشيّته نافذة فلا أمن بمعنى انتفاء القدرة على ما يخالف الوعد فالخوف على حاله و لذلك نرى
أنّه تعالى يقول في ملائكته:( يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ ) فيصفهم بالخوف و هو يصرّح بعصمتهم، و يقول في أنبيائه:( وَ يَخْشَوْنَهُ وَ لا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللهَ ) الأحزاب: 39، و يصف المؤمنين في هذه الآية بالإشفاق و هو يعدّهم في آخر الآيات بقول جازم فيقول:( أُولئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ) .
قوله تعالى: ( إِنَّ عَذابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ) تعليل لإشفاقهم من عذاب ربّهم فيتبيّن به أنّهم مصيبون في إشفاقهم من العذاب و قد تقدّم وجهه.
قوله تعالى: ( وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ - إلى قوله -هُمُ العادُونَ ) تقدّم تفسير الآيات الثلاث في أوّل سورة المؤمنون.
قوله تعالى: ( وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ ) المتبادر من الأمانات أنواع الأمانة الّتي يؤتمنون عليها من المال و سائر ما يوصى به من نفس أو عرض و رعايتهم لها أن يحفظوها و لا يخونوها قيل: و لكثرة أنواعها جيء بلفظ الجمع بخلاف العهد.
و قيل: المراد بها جميع ما كلّفهم الله من اعتقاد و عمل فتعمّ حقوق الله و حقوق الناس فلو ضيعوا شيئاً منها فقد خانوه.
و قيل: كلّ نعمة أعطاها الله عبده من الأعضاء و غيرها أمانة فمن استعمل شيئاً منها في غير ما أعطاه الله لأجله و أذن له في استعماله فقد خانه.
و ظاهر العهد عقد الإنسان مع غيره قولاً أو فعلاً على أمر و رعايته أن يحفظه و لا ينقضه من غير مجوّز.
و قيل: العهد كلّ ما التزم به الإنسان لغيره فإيمان العبد لربّه عهد منه عاهد به ربّه أن يطيعه في كلّ ما كلّفه به فلو عصاه في شيء ممّا أمره به أو نهاه عنه فقد نقض عهده.
قوله تعالى: ( وَ الَّذِينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ ) الشهادة معروفة، و القيام بالشهادة عدم الاستنكاف عن تحمّلها و أداء ما تحمّل منها كما تحمّل من غير كتمان و لا تغيير، و الآيات في هذا المعنى كثيرة.
قوله تعالى: ( وَ الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ ) المراد بالمحافظة على الصلاة رعاية صفات كمالها على ما ندب إليه الشرع.
قيل: و المحافظة على الصلاة غير الدوام عليها فإنّ الدوام متعلّق بنفس الصلاة و المحافظة بكيفيّتها فلا تكرار في ذكر المحافظة عليها بعد ذكر الدوام عليها.
قوله تعالى: ( أُولئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ) الإشارة إلى المصلّين في قوله:( إِلَّا الْمُصَلِّينَ ) و تنكير جنّات للتفخيم، و( فِي جَنَّاتٍ ) خبر و( مُكْرَمُونَ ) خبر بعد خبر أو ظرف لقوله:( مُكْرَمُونَ ) .
( بحث روائي)
في تفسير القمّيّ:( إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً ) قال: الشرّ هو الفقر و الفاقة( وَ إِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً ) قال: الغنى و السعة.
و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرعليهالسلام قال: ثمّ استثنى فقال( إِلَّا الْمُصَلِّينَ ) فوصفهم بأحسن أعمالهم( الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ ) يقول: إذا فرض على نفسه شيئاً من النوافل دام عليه.
أقول: قوله: إذا فرض على نفسه إلخ استفادعليهالسلام هذا المعنى من إضافة الصلاة إلى ضمير( هُمْ ) و قد أشرنا إليه فيما مرّ.
و في الكافي، بإسناده إلى الفضيل بن يسار قال: سألت أباجعفرعليهالسلام عن قول الله عزّوجلّ:( وَ الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ ) قال: هي الفريضة. قلت:( الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ ) قال: هي النافلة.
و في المجمع: في قوله تعالى:( وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ) و روي عن أبي عبداللهعليهالسلام أنّه قال: الحقّ المعلوم ليس من الزكاة و هو الشيء الّذي تخرجه من مالك إن شئت كلّ جمعة و إن شئت كلّ يوم، و لكلّ ذي فضل فضله.
قال: و روي عنه أيضاً أنّه قال: هو أن تصل القرابة و تعطي من حرمك و تصدّق
على من عاداك.
أقول: و روي هذا المعنى في الكافي، عن أبي جعفر و أبي عبداللهعليهالسلام بعدّة طرق و رواه في المحاسن عن أبي جعفرعليهالسلام .
و في الكافي، بإسناده عن صفوان الجمّال عن أبي عبداللهعليهالسلام في قول الله عزّوجلّ( لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ ) قال: المحروم المحارف الّذي قد حرم كدّ يمينه في الشراء و البيع.
قال: و في رواية اُخرى عن أبي جعفر و أبي عبداللهعليهالسلام أنّهما قالا: المحروم الرجل الّذي ليس بعقله بأس و لم يبسط له في الرزق و هو محارف.
و في المجمع: في قوله تعالى:( وَ الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ ) روى محمّد بن الفضيل عن أبي الحسنعليهالسلام أنّه قال: اُولئك أصحاب الخمسين صلاة من شيعتنا.
أقول: و لعلّه مبني علىّ ما ورد عنهمعليهمالسلام أنّ تشريع النوافل اليوميّة لتتميم الفرائض.
( سورة المعارج الآيات 36 - 44)
فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ( 36 ) عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ( 37 ) أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ( 38 ) كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ( 39 ) فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ( 40 ) عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ( 41 ) فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ( 42 ) يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ ( 43 ) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ( 44 )
( بيان)
لمّا ذكر سبحانه في الفصل الأوّل من آيات السورة في ذيل ما حكى من سؤالهم العذاب أنّ لهم عذاباً واقعاً ليس له دافع و هو النار المتلظّية النزّاعة للشوى الّتي تدعو من أدبر و تولّى و جمع فأوعى.
ثم بيّن في الفصل الثاني منها الملاك في ابتلائهم بهذه الشقوة و هو أنّ الإنسان مجهّز بغريزة الهلع و حبّ خير نفسه و يؤدّيه اتّباع الهوى في استعمالها إلى الاستكبار على كلّ حقّ يواجهه فيورده ذلك النار الخالدة، و لا ينجو من ذلك إلّا الصالحون عملاً المصدّقون ليوم الدين المشفقون من عذاب ربّهم.
انعطف في هذا الفصل من الآيات - و هو الفصل الثالث - على اُولئك الكفّار كالمتعجّب من أمرهم حيث يجتمعون على النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم : مهطعين عن اليمين و عن
الشمال عزين مقبلين عليه بأبصارهم لا يفارقونه فخاطبهصلىاللهعليهوآلهوسلم : ما بالهم يحيطون بك مهطعين عليك يلازمونك؟ هل يريد كلّ امرء منهم أن يُدخل جنّة نعيم و هو كافر و قد قدّر الله سبحانه أن لا يكرم بجنّته إلّا من استثناه من المؤمنين فهل يريدون أن يسبقوا الله و يعجزوه بنقض ما حكم به و إبطال ما قدّره كلّا إنّ الله الّذي خلقهم من نطفة مهينة قادر أن يبدلهم خيراً منهم و يخلق ممّا خلقهم منه، غيرهم ممّن يعبده و يدخل جنّته.
ثمّ أمر النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم أن يقطع خصامهم و يذرهم يخوضوا و يلعبوا حتّى يلاقوا يومهم الّذي يوعدون.
قوله تعالى: ( فَما لِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشِّمالِ عِزِينَ ) قال في المجمع: قال الزّجاج: المهُطع المقبل ببصره على الشيء لا يزايله و ذلك من نظر العدوّ، و قال أبوعبيدة الإهطاع الإسراع، و عزين جماعات في تفرقة، واحدتهم عزّة. انتهى، و قِبلُ الشيء بالكسر فالفتح الجهة الّتي تليه و الفاء في( فما ) فصيحة.
و المعنى: إذا كان الإنسان بكفره و استكباره على الحقّ مصيره إلى النار إلّا من استثني من المؤمنين فما للّذين كفروا عندك مقبلين عليك لا يرفعون عنك أبصارهم و هم جماعات متفرّقة عن يمينك و شمالك أ يطمعون أن يدخلوا الجنّة فيعجزوا الله و يسبقوه فيما قضى به أن لا يدخل الجنّة إلّا الصلحاء من المؤمنين.
قوله تعالى: ( أَ يَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ) ، الاستفهام للإنكار أي - ما هو الّذي يحملهم على أن يحتفّوا بك و يهطعوا عليك؟ - هل يحملهم على ذلك طمع كلّ منهم أن يدخل جنّة نعيم و هو كافر فلا مطمع للكافر في دخول الجنّة.
و نسب الطمع إلى كلّ امرء منهم و لم ينسب إلى جماعتهم بأن يقال: أ يطمعون أن يدخلوا إلخ كما نسب الإهطاع إلى جماعتهم فقيل: مهطعين لأنّ النافع من الطمع في السعادة و الفلاح هو الطمع القائم بنفس الفرد الباعث له إلى الإيمان و العمل الصالح دون القائم بالجماعة بما أنّها جماعة فطمع المجموع من حيث أنّه مجموع لا يكفي في سعادة كلّ واحد واحد.
و في قوله:( أَنْ يُدْخَلَ ) مجهولاً من باب الإفعال إشارة إلى أنّ دخولهم في الجنّة ليس منوطاً باختيارهم و مشيّتهم بل لو كان فإنّما هو إلى الله سبحانه فهو الّذي يدخلهم الجنّة إن شاء و لن يدخل بما قدّر أن لا يدخلها كافر.
قيل: إنّ النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصلّي عند الكعبة و يقرأ القرآن فكان المشركون يجتمعون حوله حلقاً حلقاً و فرقاً يستمعون و يستهزؤن بكلامه، و يقولون إن دخل هؤلاء الجنّة كما يقول محمّدصلىاللهعليهوآلهوسلم فلندخلها قبلهم فنزلت الآيات.
و هذا القول لا يلائمه سياق الآيات الظاهر في تفرّع صنعهم ذلك على ما مرّ من حرمان الناس من دخول الجنّة إلّا من استثني من المؤمنين إذ من الضروري على هذا أنّ اجتماعهم حولهصلىاللهعليهوآلهوسلم و إهطاعهم عليه إنّما حملهم عليه إفراطهم في عداوته و مبالغتهم في إيذائه و إهانته، و أنّ قولهم: سندخل الجنّة قبل المؤمنين - و هم مشركون مصرّون على إنكار المعاد غير معترفين بنار و لا جنّة - إنّما كان استهزاء و تهكّما.
فلا مساغ لتفريع عملهم ذاك على ما تقدّم من حديث النار و الجنّة و السؤال - في سياق التعجيب - عن السبب الحامل لهم عليه ثمّ استفهام طمعهم في دخول الجنّة و إنكاره عليهم.
فبما تقدّم يتأيّد أن يكون المراد بالّذين كفروا في قوله:( فَما لِ الَّذِينَ كَفَرُوا ) قوماً من المنافقين آمنوا بهصلىاللهعليهوآلهوسلم ظاهراً و لازموه ثمّ كفروا بردّ بعض ما نزل عليه كما يشير إليه أمثال قوله تعالى:( ذلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ ) المنافقون 3، و قوله:( لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ ) التوبة 66، و قوله:( فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِي قُلُوبِهِمْ ) التوبة 77.
فهؤلاء قوم كانوا قد آمنوا و دخلوا في جماعة المؤمنين و لازموا النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم مهطعين عليه عن اليمين و عن الشمال عزين ثمّ كفروا ببعض ما نزل إليه لا يبالون به فقرعهم الله سبحانه في هذه الآيات أنّهم لا ينتفعون بملازمته و لا لهم أن يطمعوا في دخول الجنّة فليسوا ممّن يدخلها و ليسوا بسابقين و لا معجزين.
و يؤيّده قوله الآتي:( إِنَّا لَقادِرُونَ عَلى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْراً مِنْهُمْ ) إلخ على ما سنشير إليه.
قوله تعالى: ( كَلَّا إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ) ردع لهم عن الطمع في دخول الجنّة مع كفرهم.
و قوله:( إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ) المراد بما يعلمون النطفة فإنّ الإنسان مخلوق منها، و الكلام مرتبط بما بعده و المجموع تعليل للردع، و محصّل التعليل أنّا خلقناهم من النطفة - و هم يعلمون به - فلنا أن نذهب بهم و نخلق مكانهم قوماً آخرين يكونون خيراً منهم مؤمنين غير رادّين لشيء من دين الله، و لسنا بمسبوقين حتّى يعجزنا هؤلاء الكفّار و يسبقونا فندخلهم الجنّة و ينتقض به ما قدّرنا أن لا يدخل الجنّة كافر.
و قيل:( من ) في قوله:( مِمَّا يَعْلَمُونَ ) تفيد معنى لام التعليل، و المعنى أنّا خلقناهم لأجل ما يعلمون و هو الاستكمال بالإيمان و الطاعة فمن الواجب أن يتلبّسوا بذلك حتّى ندخلهم الجنّة فكيف يطمعون في دخولها و هم كفّار؟ و إنّما علموا بذلك من طريق إخبار النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم .
و قيل:( من ) لابتداء الغاية، و المعنى: إنّا خلقناهم من نطفة قذرة لا تناسب عالم القدس و الطهارة حتّى تتطهّر بالإيمان و الطاعة و تتخلّق بأخلاق الملائكة فتدخل و أنّى لهم ذلك و هم كفّار.
و قيل: المراد بما في( مِمَّا يَعْلَمُونَ ) الجنس، و المعنى إنّا خلقناهم من جنس الآدميّين الّذين يعلمون أو من الخلق الّذين يعلمون لا من جنس الحيوانات الّتي لا تعقل و لا تفقه فالحجّة لازمة لهم تامّة عليهم، و الوجوه الثلاثة سخيفة.
قوله تعالى: ( فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَ الْمَغارِبِ إِنَّا لَقادِرُونَ عَلى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْراً مِنْهُمْ وَ ما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ) المراد بالمشارق و المغارب مشارق الشمس و مغاربها فإنّ لها في كلّ يوم من أيّام السنة الشمسيّة مشرقاً و مغرباً لا يعود إليهما إلى مثل اليوم من السنة القابلة، و من المحتمل أن يكون المراد بها مشارق جميع النجوم
و مغاربها.
و في الآية على قصرها وجوه من الالتفات ففي قوله:( فَلا أُقْسِمُ ) التفات من التكلّم مع الغير في( إِنَّا خَلَقْناهُمْ ) إلى التكلّم وحده، و الوجه فيه تأكيد القسم بإسناده إلى الله تعالى نفسه.
و في قوله:( بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَ الْمَغارِبِ ) التفات من التكلّم وحده إلى الغيبة، و الوجه فيه الإشارة إلى صفة من صفاته تعالى هي المبدأ في خلق الناس جيلا بعد جيلا و هي ربوبيّته للمشارق و المغارب فإنّ الشروق بعد الشروق و الغروب بعد الغروب الملازم لمرور الزمان دخلاً تامّاً في تكون الإنسان جيلا بعد جيل و سائر الحوادث الأرضيّة المقارنة له.
و في قوله:( إِنَّا لَقادِرُونَ ) التفات من الغيبة إلى التكلّم مع الغير، و الوجه فيه الإشارة إلى العظمة المناسبة لذكر القدرة، و في ذكر ربوبيّته للمشارق و المغارب إشارة إلى تعليل القدرة فإنّ الّذي ينتهي إليه تدبير الحوادث في تكوّنها لا يعجزه شيء من الحوادث الّتي هي أفعاله عن شيء منها و لا يمنعه شيء من خلقه من أن يبدّله خيراً منه و إلّا شاركه المانع في أمر التدبير و الله سبحانه واحد لا شريك له في ربوبيّته فافهم ذلك.
و قوله:( إِنَّا لَقادِرُونَ عَلى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْراً مِنْهُمْ ) ( عَلى ) متعلّق بقوله:( لَقادِرُونَ ) و المفعول الأوّل لنبدّل ضمير محذوف راجع إليهم و إنّما حذف للإشارة إلى هوان أمرهم و عدم الاهتمام بهم، و( خَيْراً ) مفعوله الثاني و هو صفة اُقيمت مقام موصوفها، و التقدير إنّا لقادرون على أن نبدّلهم قوماً خيراً منهم، و خيريّتهم منهم أن يؤمنوا بالله و لا يكفروا به و يتّبعوا الحقّ و لا يردّوه.
و قوله:( وَ ما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ) المراد بالسبق الغلبة على سبيل الاستعارة، و كونه تعالى مسبوقاً هو أن يمنعه خلقهم أن يذهب بهم و يأتي بدلهم بقوم خير منهم.
و سياق الآية لا يخلو من تأييد مّا لما تقدّم من كون المراد بالّذين كفروا قوماً من المنافقين دون المشركين المعاندين للدين النافين لأصل المعاد فإنّ ظاهر قوله:
( خَيْراً مِنْهُمْ ) لا يخلو من دلالة أو إشعار بأنّ فيهم شائبة خيريّة و لله أن يبدّل خيراً منهم، و المشركون لا خير فيهم لكن هذه الطائفة من المنافقين لا يخلو تحفّظهم على ظواهر الدين ممّا آمنوا به و لم يردّوه من خير للإسلام.
فقد بان بما تقدّم أنّ قوله:( إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ) إلى آخر الآيات الثلاث تعليل للردع بقوله:( كَلَّا ) ، و أنّ محصّل مضمون الآيات الثلاث أنّهم مخلوقون من نطفة - و هم يعلمون ذلك - و هي خلقة جارية و الله الّذي هو ربّ الحوادث الجارية الّتي منها خلق الإنسان جيلاً بعد جيل و المدبّر لها قادر أن يذهب بهم و يبدّلهم خيراً منهم يعتنون بأمر الدين و يستأهلون لدخول الجنّة، و لا يمنعه خلق هؤلاء أن يبدّلهم خيراً منهم و يدخلهم الجنّة بكمال إيمانهم من غير أن يضطرّ إلى إدخال هؤلاء الجنّة فلا ينتقض تقديره أنّ الجنّة للصالحين من أهل الإيمان.
قوله تعالى: ( فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَ يَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ) أمر للنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم أن يتركهم و ما هم فيه، و لا يلحّ عليهم بحجاج و لا يتعب نفسه فيهم بعظة، و قد سمّي ما هم عليه بالخوض و اللعب دلالة على أنّهم لا ينتفعون به انتفاعاً حقيقيّاً على ما لهم فيه من الإمعان و الإصرار كاللعب الّذي لا نفع فيه وراء الخيال فليتركوا حتّى يلاقوا اليوم الّذي يوعدون و هو يوم القيامة.
و في إضافة اليوم إليهم إشارة إلى نوع اختصاص له بهم و هو الاختصاص بعذابهم.
قوله تعالى: ( يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ سِراعاً كَأَنَّهُمْ إِلى نُصُبٍ يُوفِضُونَ ) بيان ليومهم الّذي يوعدون و هو يوم القيامة.
و الأجداث جمع جدث و هو القبر، و سراعاً جمع سريع، و النصب ما ينصب علامة في الطريق يقصده السائرون للاهتداء به، و قيل: هو الصنم المنصوب للعبادة و هو بعيد من كلامه تعالى، و الإيفاض الإسراع و المعنى ظاهر.
قوله تعالى: ( خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كانُوا يُوعَدُونَ ) الخشوع تأثّر خاصّ في القلب عن مشاهدة العظمة و الكبرياء، و يناظره الخضوع في الجوارح، و نسبة الخشوع إلى الأبصار لظهور آثاره فيها، و الرهق غشيان الشيء بقهر.
و قوله:( ذلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كانُوا يُوعَدُونَ ) الإشارة إلى ما مرّ من أوصافه من الخروج من الأجداث سراعاً و خشوع الأبصار و رهق الذلّة.
( بحث روائي)
في الدرّ المنثور، أخرج عبد بن حميد عن عبادة بن أنس قال: دخل رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم المسجد فقال: ما لي أراكم عزين حلقاً حلق الجاهليّة قعد رجل خلف أخيه.
أقول: و رواه عن ابن مردويه عن أبي هريرة و لفظه: خرج رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم و أصحابه جلوس حلقاً حلقاً فقال: ما لي أراكم عزين، و روي هذا المعنى أيضاً عن جابر بن سمرة.
و في تفسير القمّيّ: و قوله:( كَلَّا إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ) قال: من نطفة ثمّ علقة، و قوله:( فَلا أُقْسِمُ ) أي اُقسم( بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَ الْمَغارِبِ ) قال: مشارق الشتاء و مشارق الصيف و مغارب الشتاء و مغارب الصيف.
و في المعاني، بإسناده إلى عبدالله بن أبي حماد رفعه إلى أميرالمؤمنينعليهالسلام قال: لها ثلاثمائة و ستّون مشرقاً و ثلاثمائة و ستّون مغرباً فيومها الّذي تشرق فيه لا تعود فيه إلّا من قابل.
و في تفسير القمّيّ: و قوله:( يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ سِراعاً ) قال: من القبر( كَأَنَّهُمْ إِلى نُصُبٍ يُوفِضُونَ ) قال: إلى الداعي ينادون، و قوله:( تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ) قال: تصيبهم ذلّة.
( سورة نوح مكّيّة و هي ثمان و عشرون آية)
( سورة نوح الآيات 1 - 24)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( 1 ) قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ( 2 ) أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ( 3 ) يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ( 4 ) قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ( 5 ) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ( 6 ) وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ( 7 ) ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ( 8 ) ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ( 9 ) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ( 10 ) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ( 11 ) وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا ( 12 ) مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ( 13 ) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ( 14 ) أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ( 15 ) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ( 16 ) وَاللهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ( 17 ) ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ( 18 ) وَاللهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ( 19 ) لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ( 20 ) قَالَ نُوحٌ رَّبِّ
إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ( 21 ) وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ( 22 ) وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ( 23 ) وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ( 24 )
( بيان)
تشير السورة إلى رسالة نوحعليهالسلام إلى قومه و إجمال دعوته و عدم استجابتهم له ثمّ شكواه إلى ربّه منهم و دعائه عليهم و استغفاره لنفسه و لوالديه و لمن دخل بيته مؤمناً و للمؤمنين و المؤمنات ثمّ حلول العذاب بهم و إهلاكهم بالإغراق و السورة مكّيّة بشهادة سياق آياتها.
قوله تعالى: ( إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ) ( أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ ) إلخ، تفسير لرسالته أي أوحينا إليه أن أنذر إلخ.
و في الكلام دلالة على أنّ قومه كانوا عرضة للعذاب بشركهم و معاصيهم كما يدلّ عليه ما حكي من قولهعليهالسلام في الآية التالية:( اعْبُدُوا اللهَ وَ اتَّقُوهُ ) و ذلك أنّ الإنذار تخويف و التخويف إنّما يكون من خطر محتمل لا دافع له لو لا التحذّر، و قد أفاد قوله:( مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ) أنّه متوجّه إليهم غير تاركهم لو لا تحذّرهم منه.
قوله تعالى: ( قالَ يا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَ اتَّقُوهُ وَ أَطِيعُونِ ) بيان لتبليغه رسالته إجمالاً بقوله:( إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ) و تفصيلاً بقوله:( أَنِ اعْبُدُوا اللهَ ) إلخ.
و في إضافته اليوم إلى نفسه إظهار إشفاق و رحمة أي إنّكم قومي يجمعكم و إيّاي مجتمعنا القوميّ تسوؤني ما أساءكم فلست اُريد إلّا ما فيه خيركم و سعادتكم إنّي
لكم نذير إلخ.
و في قوله:( أَنِ اعْبُدُوا اللهَ ) دعوتهم إلى توحيده تعالى في عبادته فإنّ القوم كانوا وثنيّين يعبدون الأصنام، و الوثنيّة لا تجوّز عبادة الله سبحانه لا وحده و لا مع غيره، و إنّما يعبدون أرباب الأصنام بعبادة الأصنام ليكونوا شفعاء لهم عند الله، و لو جوّزوا عبادته تعالى لعبدوه وحده فدعوتهم إلى عبادة الله دعوة لهم إلى توحيده في العبادة.
و في قوله:( وَ اتَّقُوهُ ) دعوتهم إلى اجتناب معاصيه من كبائر الإثم و صغائره و هي الشرك فما دونه، و فعل الأعمال الصالحة الّتي في تركها معصية.
و في قوله:( وَ أَطِيعُونِ ) دعوة لهم إلى طاعة نفسه المستلزم لتصديق رسالته و أخذ معالم دينهم ممّا يعبد به الله سبحانه و يستنّ به في الحياة منهعليهالسلام ففي قوله:( اعْبُدُوا اللهَ وَ اتَّقُوهُ وَ أَطِيعُونِ ) ندب إلى اُصول الدين الثلاثة: التوحيد المشار إليه بقوله:( اعْبُدُوا اللهَ ) و المعاد الّذي هو أساس التقوى(1) و التصديق بالنبوّة المشار إليه بالدعوة إلى الطاعة المطلقة.
قوله تعالى: ( يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ) مجزوم في جواب الأمر و كلمة( مِنْ ) للتبعيض على ما هو المتبادر من السياق، و المعنى أن تعبدوه و تتّقوه و تطيعوني يغفر لكم بعض ذنوبكم و هي الذنوب الّتي قبل الإيمان: الشرك فما دونه، و أمّا الذنوب الّتي لم تقترف بعد ممّا سيستقبل فلا معنى لمغفرتها قبل تحقّقها، و لا معنى أيضاً للوعد بمغفرتها إن تحقّقت في المستقبل أو كلّما تحقّقت لاستلزام ذلك إلغاء التكاليف الدينيّة بإلغاء المجازاة على مخالفتها.
و يؤيّد ذلك ظاهر قوله تعالى:( يا قَوْمَنا أَجِيبُوا داعِيَ اللهِ وَ آمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ) الأحقاف: 31، و قوله:( يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ) إبراهيم: 10 و قوله:( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ ) الأنفال: 38.
____________________
(1) إذ لو لا المعاد بما فيه من الحساب و الجزاء لم يكن للتقوى الدينيّ وجه، منه.
و أمّا قوله تعالى يخاطب المؤمنين من هذه الاُمّة:( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ يُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ ) الصفّ: 12 فهو و إن كان ظاهراً في مغفرة جميع الذنوب لكن رتّبت المغفرة فيه على استمرار الإيمان و العمل الصالح و إدامتهما ما دامت الحياة فلا مغفرة فيه متعلّقة بما لم يتحقّق بعد من المعاصي و الذنوب المستقبلة و لا وعد بمغفرتها كلّما تحقّقت.
و قد مال بعضهم اعتماداً على عموم المغفرة في آية الصفّ إلى القول بأنّ المغفور بسبب الإيمان في هذه الاُمّة جميع الذنوب و في سائر الاُمم بعضها كما هو ظاهر قول نوح لاُمّته:( يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ) و قول الرسل: كما في سورة إبراهيم( يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ) و قول الجنّ كما في سورة الأحقاف لقومهم:( يا قَوْمَنا أَجِيبُوا داعِيَ اللهِ وَ آمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ) .
و فيه أنّ آية الصفّ موردها غير مورد المغفرة بسبب الإيمان فقط كما أشرنا إليه. على أنّ آية الأنفال صريحة في مغفرة ما قد سلف، و المخاطب به كفّار هذه الاُمّة.
و ذهب بعضهم إلى كون( مِنْ ) في قوله:( مِنْ ذُنُوبِكُمْ ) زائدة، و لم تثبت زيادة( من ) في الإثبات فهو ضعيف و مثله في الضعف قول من ذهب إلى أنّ( مِنْ ) بيانيّة، و قول من ذهب إلى أنّها لابتداء الغاية.
قوله تعالى: ( وَ يُؤَخِّرْكُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذا جاءَ لا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) تعليق تأخيرهم إلى أجل مسمّى على عبادة الله و التقوى و طاعة الرسول يدلّ على أنّ هناك أجلين أجل مسمّى يؤخّرهم الله إليه إن أجابوا الدعوة، و أجل غيره يعجّل إليهم لو بقوا على الكفر، و أنّ الأجل المسمّى أقصى الأجلين و أبعدهما.
ففي الآية وعدهم بالتأخير إلى الأجل المسمّى إن آمنوا و في قوله:( إِنَّ أَجَلَ
اللهِ إِذا جاءَ لا يُؤَخَّرُ ) تعليل للتأخير إلى الأجل المسمّى إن آمنوا فالمراد بأجل الله إذا جاء مطلق الأجل المقضيّ المتحتّم أعمّ من الأجل المسمّى و غير المسمّى فلا رادّ لقضائه تعالى و لا معقّب لحكمه.
و المعنى: أن اعبدوا الله و اتّقوه و أطيعوني يؤخّركم الله إلى أجل مسمّى هو أقصى الأجلين فإنّكم إن لم تفعلوا ذلك جاءكم الأجل غير المسمّى بكفركم و لم تؤخّروا فإنّ أجل الله إذا جاء لا يؤخّر، ففي الكلام مضافاً إلى وعد التأخير إلى الأجل المسمّى إن آمنوا، تهديد بعذاب معجّل إن لم يؤمنوا.
و قد ظهر بما تقدّم عدم استقامة تفسير بعضهم لأجل الله بالأجل غير المسمّى و أضعف منه تفسيره بالأجل المسمّى.
و ذكر بعضهم: أنّ المراد بأجل الله يوم القيامة و الظاهر أنّه يفسّر الأجل المسمّى أيضاً بيوم القيامة فيرجع معنى الآية حينئذ إلى مثل قولنا: إن لم تؤمنوا عجّل الله إليكم بعذاب الدنيا و إن آمنتم أخّركم إلى يوم القيامة إنّه إذا جاء لا يؤخّر.
و أنت خبير بأنّه لا يلائم التبشير الّذي في قوله:( يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ) .
و قوله:( لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) متعلّق بأوّل الكلام أي لو كنتم تعلمون أنّ لله أجلين و أنّ أجله إذا جاء لا يؤخّر استجبتم دعوتي و عبدتم الله و اتّقيتموه و أطعتموني هذا فمفعول( تَعْلَمُونَ ) محذوف يدلّ عليه سابق الكلام.
و قيل: إنّ( تَعْلَمُونَ ) منزّل منزلة الفعل اللازم، و جواب لو متعلّق بأوّل الكلام، و المعنى: لو كنتم من أهل العلم لاستجبتم دعوتي و آمنتم، أو متعلّق بآخر الكلام، و المعنى: لو كنتم من أهل العلم لعلمتم أنّ أجل الله إذا جاء لا يؤخّر.
قوله تعالى: ( قالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَ نَهاراً فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إِلَّا فِراراً ) القائل هو نوحعليهالسلام و الّذي دعا إليه هو عبادة الله و تقواه و طاعة رسوله، و الدعاء ليلاً و نهاراً كناية عن دوامه من غير فتور و لا توان.
و قوله:( فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إِلَّا فِراراً ) أي من إجابة دعوتي فالمراد بالفرار التمرّد و التأبّي عن القبول استعارة، و إسناد زيادة الفرار إلى دعائه لما فيه من شائبة
السببيّة لأنّ الخير إذا وقع في محلّ غير صالح قاومه المحلّ بما فيه من الفساد فأفسده فانقلب شرّاً، و قد قال تعالى في صفة القرآن:( وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً ) إسراء: 82.
قوله تعالى: ( وَ إِنِّي كُلَّما دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ وَ اسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ ) إلخ ذكر مغفرته تعالى غاية لدعوته و الأصل (دعوتهم ليؤمنوا فتغفر لهم) لأنّ الغرض الإشارة إلى أنّه كان ناصحاً لهم في دعوته و لم يرد إلّا ما فيه خير دنياهم و عقباهم.
و قوله:( جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ ) كناية عن استنكافهم عن الاستماع إلى دعوته، و قوله:( وَ اسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ ) أي غطوا بها رؤسهم و وجوههم لئلّا يروني و لا يسمعوا كلامي و هو كناية عن التنفّر و عدم الاستماع إلى قوله.
و قوله:( وَ أَصَرُّوا وَ اسْتَكْبَرُوا اسْتِكْباراً ) أي و ألحّوا على الامتناع من الاستماع و استكبروا عن قبول دعوتي استكباراً عجيباً.
قوله تعالى: ( ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهاراً ) ( ثُمَّ ) للتراخي بحسب رتبة الكلام و الجهار النداء بأعلى الصوت.
قوله تعالى: ( ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَ أَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْراراً ) الإعلان و الإسرار متقابلان و هما الإظهار و الإخفاء، و ظاهر السياق أنّ مرجع ضمير لهم في الموضعين واحد فالمعنى دعوتهم سرّاً و علانية فتارة علانية و تارة سرّاً سالكاً في دعوتي كلّ مذهب ممكن و سائراً في كلّ مسير مرجوّ.
قوله تعالى: ( فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً - إلى قوله -أَنْهاراً ) علل أمرهم بالاستغفار بقوله:( إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً ) دلالة على أنّه تعالى كثير المغفرة و هي مضافاً إلى كثرتها منه سنّة مستمرّة له تعالى.
و قوله:( يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً ) مجزوم في جواب الأمر، و المراد بالسماء السحاب، و المدرار كثير الدرور بالأمطار.
و قوله:( وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ ) الأمداد إلحاق المدد و هو ما يتقوّى به
الممد على حاجته، و الأموال و البنون أقرب الأعضاد الابتدائيّة الّتي يستعين بها المجتمع الإنسانيّ على حوائجه الحيويّة.
و قوله:( وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً ) هما من قسم الأموال غير أنّهما لكونهما من أبسط ضروريّات المعاش خصّاً بالذكر.
و الآيات - كما ترى - تعدّ النعم الدنيويّة و تحكي عنهعليهالسلام أنّه يعد قومه توافر النعم و تواترها عليهم إن استغفروا ربّهم فلمغفرة الذنوب أثر بالغ في رفع المصائب و النقمات العامّة و انفتاح أبواب النعم من السماء و الأرض أي أنّ هناك ارتباطاً خاصّاً بين صلاح المجتمع الإنسانيّ و فساده و بين الأوضاع العامّة الكونيّة المربوطة بالحياة الإنسانيّة و طيب عيشه و نكده.
كما يدلّ عليه قوله تعالى:( ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ) الروم: 41، و قوله:( وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ) الشورى: 30، و قوله:( وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ ) الأعراف: 94، و قد تقدّم في تفسير الآيات ما لا يخلو من نفع في هذا المقام.
قوله تعالى: ( ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً ) استفهام إنكاريّ و الوقار - كما في المجمع - بمعنى العظمة اسم من التوقير بمعنى التعظيم، و الرجاء مقابل الخوف و هو الظنّ بما فيه مسرّة، و المراد به في الآية مطلق الاعتقاد على ما قيل، و قيل: المراد به الخوف للملازمة بينهما.
و المعنى: أيّ سبب حصل لكم حال كونكم لا تعتقدون أو لا تخافون لله عظمة توجب أن تعبدوه.
و الحقّ أنّ المراد بالرجاء معناه المعروف و هو ما يقابل الخوف و نفيه كناية عن اليأس فكثيراً ما يكنّى به عنه يقال: لا أرجو فيه خيراً أي أنا آيس من أن يكون فيه خير، و الوقار الثبوت و الاستقرار و التمكّن و هو الأصل في معناه كما صرّح به في المجمع، و وقاره تعالى ثبوته و استقراره في الربوبيّة المستتبع لاُلوهيّته و معبوديّته.
كأنّ الوثنيّين طلبوا ربّاً له وقار في الربوبيّة لعبدوه فيئسوا منه تعالى فعبدوا غيره و هو كذلك فإنّهم يرون أنّه تعالى لا يحيط به أفهامنا فلا سبيل للتوجّه العبادي إليه، و العبادة أداء لحقّ الربوبيّة الّتي يتفرّع عليها تدبير الأمر و تدبير اُمور العالم مفوّض إلى أصناف الملائكة و الجنّ فهم أربابنا الّذين يجب علينا عبادتهم ليكونوا شفعاء لنا عند الله، و أمّا هو تعالى فليس له إلّا الإيجاد إيجاد الأرباب و مربوبيهم جميعاً دون التدبير.
و الآية أعني قوله:( ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً ) و ما يتلوها إلى تمام سبع آيات مسوقة لإثبات وقاره تعالى في الربوبيّة و حجّة قاطعة في نفي ما لفّقوه لوجوب عبادة غيره من الملائكة و غيرهم لاستناد تدبير العالم إليهم، و يتبيّن به إمكان التوجّه العبادي إليه تعالى.
و محصّل الحجّة: ما الّذي دعاكم إلى نفي ربوبيّته تعالى المستتبع للاُلوهيّة و المعبوديّة و اليأس عن وقاره؟ و أنتم تعلمون أنّه تعالى خلقكم و خلق العالم الّذي تعيشون فيه طوراً من الخلق لا ينفكّ عن هذا النظام الجاري فيه، و ليس تدبير الكون و من فيه من الإنسان إلّا التطوّرات المخلوقة في أجزائه و النظام الجاري فيه فكونه تعالى خالقاً هو كونه مالكاً مدبّراً فهو الربّ لا ربّ سواه فيجب أن يتّخذ إلهاً معبوداً.
و يتبيّن به صحّة التوجّه إليه تعالى بالعبادة فإنّا نعرفه بصفاته الكريمة من الخلق و الرزق و الرحمة و سائر صفاته الفعلية فلنا أن نتوجّه إليه بما نعرفه من صفاته(1) .
قوله تعالى: ( وَ قَدْ خَلَقَكُمْ أَطْواراً ) حال من فاعل( لا تَرْجُونَ ) و الأطوار جمع طور و هو حدّ الشيء و حاله الّتي هو عليها.
____________________
(1) و إنّما أخذناه بما نعرفه من صفاته الفعليّة لأنّ من المنسوب إليهم أنّهم ينكرون صفاته الذاتيّة و يفسّرونها بسلب النقائص فمعنى كونه حيّاً قديراً عليماً عندهم أنّه ليس بميت و لا عاجز و لا جاهل على أنّ الآيات أيضاً تصفه بالصفات الفعليّة، منه.
و محصّل المعنى - لا ترجون لله وقاراً في ربوبيّة - و الحال أنّه أنشأكم طوراً بعد طور يستعقب طوراً آخر فأنشأ الواحد منكم تراباً ثمّ نطفة ثمّ علقة ثمّ مضغة ثمّ جنينا ثمّ طفلاً ثمّ شاباً ثمّ شيخاً و أنشأ جمعكم مختلفة الأفراد في الذكورة و الاُنوثة و الألوان و الهيئات و القوّة و الضعف إلى غير ذلك، و هل هذا إلّا التدبير فهو مدبّر أمركم فهو ربّكم.
قوله تعالى: ( أَ لَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً ) مطابقة السماوات السبع بعضها لبعض كون بعضها فوق بعض أو تطابقهنّ و تماثلهنّ على الاحتمالين المتقدّمين في تفسير أوائل سورة الملك.
و المراد بالرؤية العلم، و توصيف السماوات السبع - و الكلام مسوق سوق الحجّة - يدلّ على أنّهم كانوا يرون كونها سبعاً و يسلّمون ذلك فاحتجّ عليهم بالمسلّم عندهم.
و كيف كان فوقوع حديث السماوات السبع في كلام نوح دليل على كونه مأثوراً من الأنبياءعليهمالسلام من أقدم العهود.
قوله تعالى: ( وَ جَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَ جَعَلَ الشَّمْسَ سِراجاً ) الآيات - كما يشهد به سياقها - مسوقة لبيان وقوع التدبير الإلهيّ على الإنسان بما يفيض عليه من النعم حتّى تثبت ربوبيّته فتجب عبادته.
و على هذا فكون الشمس سراجاً هو كونها مضيئة لعالمنا و لولاها لانغمرنا في ظلمة ظلماء، و كون القمر نوراً هو كونه منوّراً لأرضنا بنور مكتسب من الشمس فليس منوّراً بنفسه حتّى يعدّ سراجاً.
و أمّا أخذ السماوات ظرفاً للقمر في قوله:( وَ جَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً ) فالمراد به كما قيل كونه في حيّزهنّ و إن كان في واحدة منها كما تقول: إنّ في هذه الدور لبئراً و إن كانت في واحدة منها لأنّ ما كان في إحداهنّ كان فيهنّ و كما تقول: أتيت بني تميم و إنّما أتيت بعضهم.
قوله تعالى: ( وَ اللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً ) أي أنبتكم إنبات النبات و ذلك أنّ الإنسان تنتهي خلقته إلى عناصر أرضيّة تركّبت تركّباً خاصّاً به يغتذي و ينمو و يولّد المثل، و هذه حقيقة النبات، فالكلام مسوق سوق الحقيقة من غير تشبيه و استعارة.
قوله تعالى: ( ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيها وَ يُخْرِجُكُمْ إِخْراجاً ) الإعادة فيها بالإماتة و الإقبار، و الإخراج للجزاء يوم القيامة فالآية و الّتي قبلها قريبتا المعنى من قوله تعالى:( فِيها تَحْيَوْنَ وَ فِيها تَمُوتُونَ وَ مِنْها تُخْرَجُونَ ) الأعراف: 25.
و في قوله:( وَ يُخْرِجُكُمْ ) دون أن يقول: ثمّ يخرجكم إيماء إلى أنّ الإعادة و الإخراج كالصنع الواحد و الإعادة مقدّمة للإخراج، و الإنسان في حالتي الإعادة و الإخراج في دار الحقّ كما أنّه في الدنيا في دار الغرور.
قوله تعالى: ( وَ اللهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِساطاً ) أي كالبساط يسهل لكم التقلّب من جانب إلى جانب، و الانتقال من قطر إلى قطر.
قوله تعالى: ( لِتَسْلُكُوا مِنْها سُبُلًا فِجاجاً ) السبل جمع سبيل بمعنى الطريق و الفجاج جمع فجّ بمعنى الطريق الواسعة، و قيل: الطريق الواقعة بين الجبلين.
قوله تعالى: ( قالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَ اتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مالُهُ وَ وَلَدُهُ إِلَّا خَساراً ) رجوع منهعليهالسلام إلى شكواه من قومه إلى ربّه بعد ما ذكر تفصيل دعوته لهم و ما ألقاه من القول إليهم من قوله:( ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهاراً ) إلى آخر الآيات.
و شكواه السابق له قوله:( فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إِلَّا فِراراً ) بعد ما أخبر بإجمال دعوته بقوله:( رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَ نَهاراً ) .
و في الآية دلالة على أنّ العظماء المترفين من قومهعليهالسلام كانوا يصدّون الناس عنه و يحرّضونهم على مخالفته و إيذائه.
و معنى قوله:( لَمْ يَزِدْهُ مالُهُ وَ وَلَدُهُ إِلَّا خَساراً ) - و قد عدّ المال و الولد في سابق كلامه من النعم - أنّ المال و الولد الّذين هما من نعمك و كان يجب عليهم شكرهما لم يزيداهم إلّا كفراً و أورثهم ذلك خسراناً من رحمتك.
قوله تعالى: ( وَ مَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً ) الكبّار اسم مبالغة من الكبر.
قوله تعالى: ( وَ قالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَ لا تَذَرُنَّ وَدًّا وَ لا سُواعاً وَ لا يَغُوثَ وَ يَعُوقَ وَ نَسْراً ) توصية منهم بالتمسّك بآلهتهم و عدم ترك عبادتها.
و ودّ و سواع و يغوث و يعوق و نسر خمس من آلهتهم لهم اهتمام تامّ بعبادتهنّ و لذا خصّوها بالذكر مع الوصيّة بمطلق الآلهة، و لعلّ تصدير ودّ و ذكر سواع و يغوث بلا المؤكّدة للنفي لكونها أعظم أمراً عندهم من يعوق و نسر و الله أعلم.
قوله تعالى: ( وَ قَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً وَ لا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلالًا ) ضمير( أَضَلُّوا ) للرؤساء المتبوعين و يتأيّد به أنّهم هم المحدّث عنهم في قوله:( وَ مَكَرُوا ) ( وَ قالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ ) و قيل: الضمير للأصنام فهم المضلّون، و لا يخلو من بعد.
و قوله:( وَ لا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلالًا ) دعاء من نوح على الظالمين بالضلال و المراد به الضلال مجازاة دون الضلال الابتدائيّ فهو دعاء منه أن يجازيهم الله بكفرهم و فسقهم مضافاً إلى ما سيحكي عنه من دعائه عليهم بالهلاك.
( بحث روائي)
في نهج البلاغة: و قد جعل الله سبحانه الاستغفار سبباً لدرور الرزق و رحمة الخلق فقال سبحانه:( اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ ) فرحم الله امرأ استقبل توبته، و استقال خطيئته، و بادر منيّته.
أقول: و الروايات في استفادة سببيّة الاستغفار لسعة الرزق و الأمداد بالأولاد من هذه الآيات كثيرة.
و في الخصال، عن عليّعليهالسلام في حديث الأربعمائة: أكثر الاستغفار تجلب الرزق.
و في تفسير القمّيّ، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرعليهالسلام في قوله تعالى:( لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً ) قال؟ لا تخافون لله عظمة.
أقول: و قد روي هذا المعنى من طرق أهل السنّة عن ابن عبّاس.
و فيه، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرعليهالسلام في قوله تعالى:( سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً ) يقول بعضها فوق بعض.
و فيه في قوله تعالى:( رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَ اتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مالُهُ وَ وَلَدُهُ إِلَّا خَساراً ) قال: اتّبعوا الأغنياء.
و في الدرّ المنثور، أخرج البخاريّ و ابن المنذر و ابن مردويه عن ابن عبّاس قال: صارت الأصنام و الأوثان الّتي كانت في قوم نوح في العرب بعد.
أمّا ودّ فكانت لكلب في دومة الجندل، و أمّا سواع فكانت لهذيل، و أمّا يغوث فكانت لمراد ثمّ لبني غطيف عند سبأ، و أمّا يعوق فكانت لهمدان، و أمّا نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع.
و كانوا أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلمّا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم الّتي كانوا يجلسون أنصاباً و سمّوها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتّى إذا هلك اُولئك و نسخ العلم عبدت.
أقول: لعلّ المراد بصيرورة تلك الأصنام الّتي كانت لقوم نوح إلى العرب مطابقة ما عند العرب لما كان عندهم في الأسماء أو في الأوصاف و الأسماء، و أمّا انتقال تلك الأصنام بأشخاصهنّ إلى العرب فبعيد غايته.
و روي القصّة أيضاً في علل الشرائع، بإسناده عن جعفر بن محمّدعليهالسلام كما في الرواية.
و في روضة الكافي، بإسناده عن المفضّل عن أبي عبداللهعليهالسلام في حديث: فعمل نوح سفينته في مسجد الكوفة بيده فأتي بالخشب من بعد حتّى فرغ منها.
قال: فالتفت عن يساره و أشار بيده إلى موضع دار الداريّين و هو موضع دار ابن حكيم، و ذاك فرات اليوم، فقال لي يا مفضّل و هنا نصبت أصنام قوم نوح: يغوث و يعوق و نسر.
( سورة نوح الآيات 25 - 28)
مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللهِ أَنصَارًا ( 25 ) وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ( 26 ) إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ( 27 ) رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ( 28 )
( بيان)
تتضمّن الآيات هلاك القوم و تتمّة دعاء نوحعليهالسلام عليهم.
قوله تعالى: ( مِمَّا خَطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً ) إلخ( مِنْ ) لابتداء الغاية تفيد بحسب المورد التعليل و( مِمَّا ) زائدة لتأكيد أمر الخطايا و تفخيمه، و الخطيئات المعاصي و الذنوب، و تنكير النار للتفخيم.
و المعنى: من أجل معاصيهم و ذنوبهم اُغرقوا بالطوفان فأدخلوا - أدخلهم الله - ناراً لا يقدّر عذابها بقدر، و من لطيف نظم الآية الجمع بين الإغراق بالماء و إدخال النار.
و المراد بالنار نار البرزخ الّتي يعذّب بها المجرمون بين الموت و البعث دون نار الآخرة، و الآية من أدلّة البرزخ إذ ليس المراد أنّهم اُغرقوا و سيدخلون النار يوم القيامة، و لا يعبأ بما قيل: إنّ من الجائز أن يراد بها نار الآخرة.
و قوله:( فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْصاراً ) أي ينصرونهم في صرف الهلاك و العذاب عنهم. تعريض لأصنامهم و آلهتهم.
قوله تعالى: ( وَ قالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً ) الديّار
نازل الدار، و الآية تتمّة دعائهعليهالسلام عليهم، و كان قوله:( مِمَّا خَطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا ) إلخ معترضاً واقعاً بين فقرتي الدعاء للإشارة إلى أنّهم اُهلكوا لما عدّ نوح من خطيئاتهم و لتكون كالتمهيد لسؤاله الهلاك فيتبيّن أنّ إغراقهم كان استجابة لدعائه، و أنّ العذاب استوعبهم عن آخرهم.
قوله تعالى: ( إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبادَكَ وَ لا يَلِدُوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً ) تعليل لسؤال إهلاكهم عن آخرهم مفاده أن لا فائدة في بقائهم لا لمن دونهم من المؤمنين فإنّهم يضلّونهم، و لا فيمن يلدونه من الأولاد فإنّهم لا يلدون إلّا فاجراً كفّاراً - و الفجور الفسق الشنيع و الكفّار المبالغ في الكفر -.
و قد استفادعليهالسلام ما ذكره من صفتهم من الوحي الإلهيّ على ما تقدّم في تفسير قصّة نوح من سورة هود.
قوله تعالى: ( رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِوالِدَيَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ ) إلخ المراد بمن دخل بيته مؤمناً المؤمنون به من قومه، و بالمؤمنين و المؤمنات عامّتهم إلى يوم القيامة.
و قوله:( وَ لا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَباراً ) التبار الهلاك، و الظاهر أنّ المراد بالتبار ما يوجب عذاب الآخرة و هو الضلال و هلاك الدنيا بالغرق، و قد تقدّماً جميعاً في دعائه، و هذا الدعاء آخر ما نقل من كلامهعليهالسلام في القرآن الكريم.
( سورة الجنّ مكّيّة و هي ثمان و عشرون آية)
( سورة الجنّ الآيات 1 - 17)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ( 1 ) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ( 2 ) وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ( 3 ) وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا ( 4 ) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللهِ كَذِبًا ( 5 ) وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ( 6 ) وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللهُ أَحَدًا ( 7 ) وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ( 8 ) وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ( 9 ) وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ( 10 ) وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ( 11 ) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا ( 12 ) وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ( 13 ) وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ( 14 ) وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ( 15 ) وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا ( 16 ) لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ( 17 )
( بيان)
تشير السورة إلى قصّة نفر من الجنّ استمعوا القرآن فآمنوا به و أقرّوا باُصول معارفه، و تتخلّص منها إلى تسجيل نبوّة النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم ، و الإشارة إلى وحدانيّته تعالى في ربوبيّته و إلى المعاد، و السورة مكّيّة بشهادة سياقها.
قوله تعالى: ( قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقالُوا إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ ) أمر للنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم أن يقصّ القصّة لقومه، و الموحي هو الله سبحانه، و مفعول( اسْتَمَعَ ) القرآن حذف لدلالة الكلام عليه، و النفر الجماعة من ثلاثة إلى تسعة على المشهور، و قيل: بل إلى أربعين.
و العجب بفتحتين ما يدعو إلى التعجّب منه لخروجه عن العادة الجارية في مثله، و إنّما وصفوا القرآن بالعجب لأنّه كلام خارق للعادة في لفظه و معناه أتى به رجل اُمّيّ ما كان يقرأ و لا يكتب.
و الرشد إصابة الواقع و هو خلاف الغيّ، و هداية القرآن إلى الرشد دعوته إلى عقائد و أعمال تتضمّن للمتلبّس بها سعادته الواقعيّة.
و المعنى: يا أيّها الرسول قل للناس: أُوحِيَ - أي أوحى الله - إليّ أنّه استمع القرآن جماعة من الجنّ فقالوا - لقومهم لمّا رجعوا إليهم - إنّا سمعنا كلاماً مقروّاً خارقاً للعادة يهدي إلى معارف من عقائد و أعمال في التلبّس بها إصابة الواقع و الظفر بحقيقة السعادة.
( كلام في الجنّ)
الجنّ نوع من الخلق مستورون من حواسّنا يصدّق القرآن الكريم بوجودهم و يذكر أنّهم بنوعهم مخلوقون قبل نوع الإنسان، و أنّهم مخلوقون من النار كما أنّ الإنسان مخلوق من التراب قال تعالى:( وَ الْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُومِ ) الحجر: 27.
و أنّهم يعيشون و يموتون و يبعثون كالإنسان قال تعالى:( أُولئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ ) الأحقاف: 18.
و أنّ فيهم ذكوراً و إناثاً يتكاثرون بالتوالد و التناسل قال تعالى:( وَ أَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ ) الجنّ: 6.
و أنّ لهم شعوراً و إرادة و أنّهم يقدرون على حركات سريعة و أعمال شاقّة كما في قصص سليمانعليهالسلام و تسخير الجنّ له و قصّة ملكة سبأ.
و أنّهم مكلّفون كالإنسان، منهم مؤمنون و منهم كفّار، و منهم صالحون و آخرون طالحون، قال تعالى:( وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ) الذاريات: 54 و قال تعالى:( إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ) الجنّ: 2 و قال:( وَ أَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَ مِنَّا الْقاسِطُونَ ) الجنّ: 14 و قال:( وَ أَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَ مِنَّا دُونَ ذلِكَ ) الجنّ: 11 و قال تعالى:( قالُوا يا قَوْمَنا إِنَّا سَمِعْنا كِتاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَ إِلى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يا قَوْمَنا أَجِيبُوا داعِيَ اللهِ ) الأحقاف: 31 إلى غير ذلك من خصوصيّات أحوالهم الّتي تشير إليها الآيات القرآنيّة.
و يظهر من كلامه تعالى أنّ إبليس من الجنّ و أنّ له ذرّيّة و قبيلاً قال تعالى:( كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ) الكهف: 50 و قال تعالى:( أَ فَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِي ) الكهف: 50 و قال تعالى:( إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ ) الأعراف: 27.
قوله تعالى: ( فَآمَنَّا بِهِ وَ لَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنا أَحَداً ) إخبار عن إيمانهم بالقرآن و تصديقهم بأنّه حقّ، و قوله:( وَ لَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنا أَحَداً ) تأكيد لمعنى إيمانهم به أنّ إيمانهم بالقرآن إيمان بالله الّذي أنزله فهو ربّهم، و أنّ إيمانهم به تعالى إيمان توحيد لا يشركون به أحداً أبداً.
قوله تعالى: ( وَ أَنَّهُ تَعالى جَدُّ رَبِّنا مَا اتَّخَذَ صاحِبَةً وَ لا وَلَداً ) فسّر الجدّ بالعظمة و فسّر بالحظّ، و الآية في معنى التأكيد لقولهم:( وَ لَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنا أَحَداً ) .
و القراءة المشهورة( أَنَّهُ ) بالفتح، و قرئ بالكسر في هذه الآية و فيما بعدها من
الآيات - اثنا عشر مورداً - إلى قوله:( وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا ) فبالفتح و هو الأرجح لظهور سياق الآيات في أنّها مقولة قول الجنّ.
و أمّا قراءة الفتح فوجهها لا يخلو من خفاء، و قد وجّهها بعضهم بأنّ الجملة( وَ أَنَّهُ ) إلخ معطوفة على الضمير المجرور في قوله:( فَآمَنَّا بِهِ ) و التقدير و آمنّا بأنّه تعالى جدّ ربّنا إلخ فهو إخبار منهم بالإيمان بنفي الصاحبة و الولد منه تعالى على ما يقول به الوثنيّون.
و هذا إنّما يستقيم على قول الكوفيّين من النحاة بجواز العطف على الضمير المتّصل المجرور، و أمّا على قول البصريّين منهم من عدم جوازه فقد وجّهه بعضهم كما عن الفرّاء و الزّجّاج و الزمخشريّ بأنّها معطوفة على محلّ الجارّ و المجرور و هو النصب فإنّ قوله:( فَآمَنَّا بِهِ ) في معنى صدّقناه، و التقدير و صدّقنا أنّه تعالى جدّ ربّنا إلخ، و لا يخفى ما فيه من التكلّف.
و وجّهه بعضهم بتقدير حرف الجرّ في الجملة المعطوفة و ذلك مطّرد في أن و أنّ، و التقدير آمنّا به و بأنّه تعالى جدّ ربّنا إلخ.
و يرد على الجميع أعمّ من العطف على الضمير المجرور أو على محلّه أو بتقدير حرف الجرّ أنّ المعنى إنّما يستقيم حينئذ في قوله:( وَ أَنَّهُ تَعالى جَدُّ رَبِّنا ) إلخ، و قوله:( وَ أَنَّهُ كانَ يَقُولُ سَفِيهُنا ) إلخ، و أمّا بقيّة الآيات المصدّرة بأنّ كقوله:( وَ أَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ ) إلخ، و قوله:( وَ أَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ ) إلخ، و قوله:( وَ أَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ ) فلا يصحّ قطعاً فلا معنى لأن يقال: آمنّا أو صدّقنا أنّا ظنّنا أن لن تقول الإنس و الجنّ على الله شططا، أو يقال: آمنّا أو صدّقنا أنّه كان رجال من الإنس يعوذون إلخ، أو يقال: آمنّا أو صدّقنا أنّا لمسنا السماء إلخ.
و لا يندفع الإشكال إلّا بالمصير إلى ما ذكره بعضهم أنّه إذا وجّه الفتح في الآيتين الأوّليّين بتقدير الإيمان أو التصديق فليوجّه في كلّ من الآيات الباقية بما يناسبها من التقدير.
و وجّه بعضهم الفتح بأنّ قوله:( وَ أَنَّهُ تَعالى ) إلخ و سائر الآيات المصدّرة بأنّ معطوفة على قوله:( أَنَّهُ اسْتَمَعَ ) إلخ.
و لا يخفى فساده فإنّ محصّله أنّ الآيات في مقام الإخبار عمّا اُوحي إلى النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم من أقوالهم و قد اُخبر عن قولهم: إنّا سمعنا قرآناً عجباً فآمنّا به بعنوان أنّه إخبار عن قولهم ثمّ حكى سائر أقوالهم بألفاظها فالمعنى اُوحي إليّ أنّه استمع نفر من الجنّ فقالوا إنّا سمعنا كذا و كذا و اُوحي إليّ أنّه تعالى جدّ ربّنا إلخ و اُوحي إليّ أنّه كان يقول سفيهنا إلى آخر الآيات.
فيرد عليه أنّ ما وقع في صدر الآيات من لفظة( أَنَّهُ ) و( أَنَّهُمْ ) و( أَنَّا ) إن لم يكن جزء من لفظهم المحكيّ كان زائداً مخلّاً بالكلام، و إن كان جزء من كلامهم المحكيّ بلفظه لم يكن المحكيّ من مجموع أنّ و ما بعدها كلاماً تامّاً و احتاج إلى تقدير ما يتمّ به كلاماً حتّى تصحّ الحكاية، و لم ينفع في ذلك عطفه على قوله:( أَنَّهُ اسْتَمَعَ ) شيئاً فلا تغفل.
قوله تعالى: ( وَ أَنَّهُ كانَ يَقُولُ سَفِيهُنا عَلَى اللهِ شَطَطاً ) السفه - على ما ذكره الراغب - خفّة النفس لنقصان العقل، و الشطط القول البعيد من الحقّ.
و الآية أيضاً في معنى التأكيد لقولهم:( لَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنا أَحَداً ) و مرادهم بسفيههم من سبقهم من مشركي الجنّ، و قيل: المراد إبليس و هو من الجنّ، و هو بعيد من سياق قوله:( كانَ يَقُولُ سَفِيهُنا ) إلخ.
قوله تعالى: ( وَ أَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَى اللهِ كَذِباً ) اعتراف منهم بأنّهم ظنّوا أنّ الإنس و الجنّ صادقون فيما يقولون و لا يكذبون على الله فلمّا وجدوهم مشركين و سمعوهم ينسبون إليه تعالى الصاحبة و الولد أذعنوا به و قلّدوهم فيما يقولون فأشركوا مثلهم حتّى سمعوا القرآن فانكشف لهم الحقّ، و فيه تكذيب منهم للمشركين من الإنس و الجنّ.
قوله تعالى: ( وَ أَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزادُوهُمْ رَهَقاً ) قال الراغب: العوذ الالتجاء إلى الغير، و قال: رهقه الأمر غشيه بقهر انتهى.
و فسّر الرهق بالإثم، و بالطغيان، و بالخوف، و بالشرّ، و بالذلّة و الضعف، و هي تفاسير بلازم المعنى.
و المراد بعوذ الإنس بالجنّ - على ما قيل: أنّ الرجل من العرب كان إذا نزل الوادي في سفره ليلاً قال: أعوذ بعزيز هذا الوادي من شرّ سفهاء قومه، و نقل عن مقاتل أنّ أوّل من تعوذ بالجنّ قوم من اليمن ثمّ بنو حنيفة ثمّ فشا في العرب.
و لا يبعد أن يكون المراد بالعوذ بالجنّ الاستعانة بهم في المقاصد من طريق الكهانة، و إليه يرجع ما نقل عن بعضهم أنّ المعنى كان رجال من الإنس يعوذون برجال من أجل الجنّ و من معرّتهم و أذاهم.
و الضميران في قوله:( فَزادُوهُمْ ) أوّلهما لرجال من الإنس و ثانيهما لرجال من الجنّ و المعنى فزاد رجال الإنس رجال الجنّ رهقاً بالتجائهم إليهم فاستكبر رجال الجنّ و طغوا و أثموا، و يجوز العكس بأن يكون الضمير الأوّل لرجال الجنّ و الثاني لرجال الإنس، و المعنى فزاد رجال الجنّ رجال الإنس رهقاً أي إثماً و طغياناً أو ذلّة و خوفاً.
قوله تعالى: ( وَ أَنَّهُمْ ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ أَحَداً ) ضمير( أنهم ) لرجال من الإنس، و الخطاب في( ظَنَنْتُمْ ) لقومهم من الجنّ، و المراد بالبعث بعث الرسول بالرسالة فالمشركون ينكرون ذلك، و قيل: المراد به الإحياء بعد الموت، و سياق الآيات التالية يؤيّد الأوّل.
و عن بعضهم أنّ هذه الآية و الّتي قبلها ليستا من كلام الجنّ بل كلامه تعالى معترضاً بين الآيات المتضمّنة لكلام الجنّ، و عليه فضمير( أَنَّهُمْ ) للجنّ و خطاب( ظَنَنْتُمْ ) للناس، و فيه أنّه بعيد من السياق.
قوله تعالى: ( وَ أَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَ شُهُباً ) لمس السماء الاقتراب منها بالصعود إليها، و الحرس - على ما قيل - اسم جمع لحارس و لذا وصف بالمفرد و المراد بالحرس الشديد الحفّاظ الأقوياء في دفع من يريد الاستراق
منها و لذا شفّع بالشهب و هي سلاحهم.
قوله تعالى: ( وَ أَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً ) يفيد انضمام صدر الآية إلى الآية السابقة أنّ ملء السماء بالحرس الشديد و الشهب ممّا حدث أخيراً و أنّهم كانوا من قبل يقعدون من السماء مقاعد لاستماع كلام الملائكة و يفيد ذيل الآية بالتفريع على جميع ما تقدّم أنّ من يستمع الآن منّا بالقعود منها مقعداً للسمع يجد له شهاباً من صفته أنّه راصد له يرميه به الحرس.
فيتحصّل من مجموع الآيتين الإخبار بأنّهم عثروا على حادثة سماوية جديدة مقارنة لنزول القرآن و بعثة النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم و هي منع الجنّ من تلقّي أخبار السماء باستراق السمع.
و من عجيب الاستدلال ما عن بعضهم أنّ في الآيتين ردّا على من زعم أنّ الرجم حدث بعد مبعث رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم لظهور قوله:( مُلِئَتْ حَرَساً ) في أنّ الحادث هو الملء و كثرة الحرس لا أصل الحرس، و ظهور قوله:( نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ ) في أنّا كنّا نجد فيها بعض المقاعد خالياً من الحرس و الشهب، و الآن ملئت المقاعد كلّها فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً.
و يدفعه أنّه لو كان المراد بالآيتين هو الإخبار عن ملء السماء بالحرس و تكثير عددهم بحيث لا يوجد فيها مقاعد خالية منهم و قد كانت توجد قبل ذلك كان الواجب أن يتوجّه النفي في قوله:( فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً ) إلى السمع عن جميع المقاعد قبال إثبات السمع من بعض تلك المقاعد لا نفي مجرّد السمع.
سلّمنا أنّ المراد نفي السمع على الإطلاق و هو يكفي في ذلك لكن تعلّق الغرض في الكلام بالإخبار عن الامتلاء بالحرس مع كون بعض المقاعد خالية عنهم قبل ذلك، و كذا تقييد قوله:( فَمَنْ يَسْتَمِعِ ) إلخ، بقوله:( الْآنَ ) يدلّ على حدوث أمر جديد في رجم الجنّ و هو استيعاب الرجم لهم في أيّ مقعد قعدوا و المنع من السمع مطلقاً بعد ما كانوا يستمعون من بعض المقاعد من غير منع، و هذا المقدار كاف للمدّعي فيما يدّعيه.
و ليتنبّه أنّ مدلول الآية حدوث رجم الجنّ بشهاب رصد و هو غير حدوث الشهاب السماويّ و هو ظاهر فلا ورود لما قيل: أنّ الشهب السماويّة كانت من الحوادث الجوّيّة الموجودة قبل زمن النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم و نزول القرآن.
وجه عدم الورود أنّ الّذي يظهر من القرآن حدوث رجم الشياطين من الجنّ بالشهب من غير تعرّض لحدوث أصل الشهب، و قد تقدّم في تفسير أوّل سورة الصافّات بعض ما يتعلّق بهذا المقام.
قوله تعالى: ( وَ أَنَّا لا نَدْرِي أَ شَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً ) الرشد بفتحتين و الرشد بالضمّ فالسكون خلاف الغيّ و تنكير( رَشَداً ) لإفادة النوع أي نوعاً من الرشد.
هذا منهم إظهار للجهل و التحيّر فيما شاهدوه من أمر الرجم و منع شياطين الجنّ من الاطّلاع على أخبار السماء غير أنّهم تنبّهوا على أنّ ذلك لأمر ما يرجع إلى أهل الأرض إمّا خير أو شرّ و إذا كان خيراً فهو نوع هدى لهم و سعادة و لذا بدّلوا الخير و هو المقابل للشرّ من الرشد، و يؤيّده قولهم:( أَرادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ ) المشعر بالرحمة و العناية.
و قد صرّحوا بالفاعل لإرادة الرشد و حذفوه في جانب الشرّ أدباً و لا يراد شرّ من جانبه تعالى إلّا لمن استحقّه.
قوله تعالى: ( وَ أَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَ مِنَّا دُونَ ذلِكَ كُنَّا طَرائِقَ قِدَداً ) الصلاح مقابل الطلاح، و المراد بدون ذلك ما يقرب منه رتبة - على ما قيل -، و الظاهر أنّ دون بمعنى غير، و يؤيّده قوله:( كُنَّا طَرائِقَ قِدَداً ) الدالّ على التفرّق و التشتّت و الطرائق جمع طريقة و هي الطريق المطروقة المسلوكة، و القدد القطع جمع قدّة بمعنى قطعة من القدّ بمعنى القطع و صفت الطرائق بالقدد لأنّ كلّ واحدة منها مقطوعة عن غيرها تنتهي بسالكها إلى غاية غير ما ينتهي به إليه غيرها، و إلى هذا المعنى يرجع تفسير القدد بالطرائق المتفرّقة المتشتّتة.
و الظاهر أنّ المراد بقوله:( الصَّالِحُونَ ) الصالحون بحسب الطبع الأوّلي في
المعاشرة و المعاملة دون الصالحين بحسب الإيمان، و لو كان المراد صلاح الإيمان لكان الأنسب أن يذكر بعد ما سيجيء من حديث إيمانهم لمّا سمعوا الهدى.
و ذكر بعضهم أنّ قوله:( طَرائِقَ قِدَداً ) منصوب على الظرفيّة أي في طرائق قدد و هي المذاهب المتفرّقة المتشتّتة، و قال آخرون إنّه على تقدير مضاف أي ذوي طرائق، و لا يبعد أن يكون من الاستعارة بتشبيههم أنفسهم في الاختلاف و التباين بالطرق المقطوع بعضها من بعض الموصلة إلى غايات متشتّتة.
و المعنى: و أنّا منّا الصالحون طبعاً و منّا غير ذلك كنّا في مذاهب مختلفة أو ذوي مذاهب مختلفة أو كالطرق المقطوعة بعضها عن بعض.
قوله تعالى: ( وَ أَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللهَ فِي الْأَرْضِ وَ لَنْ نُعْجِزَهُ هَرَباً ) الظنّ هو العلم اليقينيّ، و الأنسب أن يكون المراد بقوله:( لَنْ نُعْجِزَ اللهَ فِي الْأَرْضِ ) إعجازه تعالى بالغلبة عليه فيما يشاء فيها و ذلك بالإفساد في الأرض و إخلال النظام الّذي يجري فيها فإنّ إفسادهم لو أفسدوا من القدر، و المراد بقوله:( وَ لَنْ نُعْجِزَهُ هَرَباً ) إعجازه تعالى بالهرب منه إذا طلبهم حتّى يفوتوه فلا يقدر على الظفر بهم.
و قيل: المعنى لن نعجزه تعالى كائنين في الأرض و لن نعجزه هرباً إلى السماء أي لن نعجزه لا في الأرض و لا في السماء هذا و هو كما ترى.
قوله تعالى: ( وَ أَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخافُ بَخْساً وَ لا رَهَقاً ) المراد بالهدى القرآن باعتبار ما يتضمّنه من الهدى، و البخس النقص على سبيل الظلم، و الرهق غشيان المكروه.
و الفاء في قوله:( فَمَنْ يُؤْمِنْ ) للتفريع و هو من تفريع العلّة على المعلول لإفادة الحجّة في إيمانهم بالقرآن من دون ريث و لا مهل.
و محصّل المعنى: أنّا لمّا سمعنا القرآن الّذي هو الهدى بادرنا إلى الإيمان به من دون مكث لأنّ من آمن به فقد آمن بربّه و من يؤمن بربّه فلا يخاف نقصاناً في خير أو غشياناً من مكروه حتّى يكفّ عن المبادرة و الاستعجال و يتروّى في الإقدام عليه لئلّا يقع في بخس أو رهق.
قوله تعالى: ( وَ أَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَ مِنَّا الْقاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً ) المراد بالإسلام تسليم الأمر لله تعالى فالمسلمون المسلمون له الأمر المطيعون له فيما يريده و يأمر به، و القاسطون هم المائلون إلى الباطل قال في المجمع: القاسط هو العادل عن الحقّ و المقسط العادل إلى الحقّ، انتهى.
و المعنى: أنّا معشر الجنّ منقسمون إلى من يسلّم لأمر الله مطيعين له، و إلى من يعدل عن التسليم لأمر الله و هو الحقّ.
و قوله:( فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً ) تحرّي الشيء توخّيه و قصده، و المعنى فالّذين أسلموا فاُولئك قصدوا إصابة الواقع و الظفر بالحقّ.
قوله تعالى: ( أَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً ) فيعذّبون بتسعّرهم و اشتعالهم بأنفسهم كالقاسطين من الإنس قال تعالى:( فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ ) البقرة: 26.
و قد عدّ كثير منهم قوله:( فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولئِكَ - إلى قوله -جَهَنَّمَ حَطَباً ) تتمّة لكلام الجنّ يخاطبون به قومهم و قيل: إنّه من كلامه تعالى يخاطب به النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم .
قوله تعالى: ( وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ) ( أَنْ ) مخفّفة من الثقيلة، و المراد بالطريقة طريقة الإسلام، و الاستقامة عليها لزومها و الثبات على ما تقتضيه من الإيمان بالله و آياته.
و الماء الغدق الكثير منه، و لا يبعد أن يستفاد من السياق أنّ قوله:( لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً ) مثل اُريد به التوسعة في الرزق، و يؤيّده قوله بعده:( لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ) .
و المعنى: و أنّه لو استقاموا أي الجنّ و الإنس على طريقة الإسلام لله لرزقناهم رزقاً كثيراً لنمتحنهم في رزقهم فالآية في معنى قوله:( وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ ) الأعراف: 96.
و الآية من كلامه تعالى معطوف على قوله في أوّل السورة:( أَنَّهُ اسْتَمَعَ ) إلخ.
قوله تعالى: ( وَ مَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذاباً صَعَداً ) العذاب الصعد هو الّذي يتصعّد على المعذّب و يغلبه، و قيل: هو العذاب الشاقّ.
و الإعراض عن ذكر الله لازم عدم الاستقامة على الطريقة و هو الأصل في سلوك العذاب، و لذا وضع موضعه ليدلّ على السبب الأصليّ في دخول النار.
و هو الوجه أيضاً في الالتفات عن التكلّم مع الغير إلى الغيبة في قوله:( ذِكْرِ رَبِّهِ ) و كان مقتضى الظاهر أن يقال: ذكرنا و ذلك أنّ صفة الربوبيّة هي المبدأ الأصلي لتعذيب المعرضين عن ذكره تعالى فوضعت موضع ضمير المتكلّم مع الغير ليدلّ على المبدإ الأصليّ كما وضع الإعراض عن الذكر موضع عدم الاستقامة ليدلّ على السبب.
قيل: و قوله:( يَسْلُكْهُ ) مضمّن معنى يدخله و لذا عديّ إلى المفعول الثاني، و المعنى ظاهر.
( بحث روائي)
في المجمع، روى الواحديّ عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال: ما قرأ رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم على الجنّ و ما رآهم، انطلق رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، و قد حيل بين الشياطين و بين خبر السماء فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم: قالوا: حيل بيننا و بين خبر السماء و اُرسلت علينا الشهب قالوا: ما ذاك إلّا من شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض و مغاربها.
فمرّ النفر الّذين أخذوا نحو تهامة بالنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم عامدين إلى سوق عكاظ و هو يصلّي بأصحابه صلاة الفجر فلمّا سمعوا القرآن استمعوا له و قالوا: هذا الّذي حال بيننا و بين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم و قالوا:( إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَ لَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنا أَحَداً ) فأوحى الله إلى نبيّهصلىاللهعليهوآلهوسلم :( قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ ) .
و رواه البخاريّ و مسلم أيضاً في الصحيح.
أقول: و روى القمّيّ في تفسيره ما يقرب منه و قد أوردنا الرواية في تفسير سورة الأحقاف في ذيل قوله:( وَ إِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ ) إلخ.
لكن ظاهر روايته أنّ النفر الّذين نزلت فيهم آيات سورة الأحقاف هم النفر الّذين نزلت فيهم هذه السورة و ظاهر آيات السورتين لا يلائم ذلك فإنّ ظاهر قولهم المنقول في سورة الأحقاف:( إِنَّا سَمِعْنا كِتاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى (مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ) يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ) الآية أنّهم كانوا مؤمنين بموسى و مصدّقين للتوراة و ظاهر آيات هذه السورة أنّهم كانوا مشركين لا يرون النبوّة و لازم ذلك تغاير الطائفتين اللّهمّ إلّا أن يمنع الظهور.
و فيه، عن علقمة بن قيس قال: قلت لعبد الله بن مسعود: من كان منكم مع النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم ليلة الجنّ؟ فقال: ما كان منّا معه أحد فقدناه ذات ليلة و نحن بمكّة فقلنا: اغتيل رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم أو استطير فانطلقنا نطلبه من الشعاب فلقيناه مقبلاً من نحو حراء فقلنا: يا رسول الله أين كنت؟ لقد أشفقنا عليك، و قلنا له: بتنا الليلة بشرّ ليلة بات بها قوم حين فقدناك، فقال لنا: إنّه أتاني داعي الجنّ فذهبت أقرئهم القرآن فذهب بنا و أرانا آثارهم و آثار نيرانهم فأمّا أن يكون صحبة منّا أحد فلا.
و فيه، و عن الربيع بن أنس قال: ليس لله تعالى جدّ و إنّما قالته الجنّ بجهالة فحكاه الله سبحانه كما قالت:، و روي ذلك عن أبي جعفر و أبي عبداللهعليهماالسلام .
أقول: المراد بالجدّ المنفيّ عنه تعالى الحظّ و البخت.
و في الاحتجاج، عن عليّعليهالسلام في حديث: فأقبل إليه الجنّ و النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم ببطن النخل فاعتذروا بأنّهم ظنّوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحداً، و لقد أقبل إليه أحد و سبعون ألفاً منهم فبايعوه على الصوم و الصلاة و الزكاة و الحجّ و الجهاد و نصح المسلمين فاعتذروا بأنّهم قالوا على الله شططا.
أقول: بيعتهم للنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم على الصوم و الصلاة إلخ، يصدّقها قولهم المحكيّ في أوّل السورة:( فَآمَنَّا بِهِ ) و قولهم:( وَ أَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدى آمَنَّا بِهِ ) ، و أمّا كيفيّة عملهم بها و خاصّة بالزكاة و الجهاد فمجهولة لنا، و اعتذارهم الأوّل المذكور لا يخلو من خفاء.
و في تفسير القمّيّ، بإسناده إلى زرارة قال: سألت أباجعفر عن قول الله:( وَ أَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزادُوهُمْ رَهَقاً ) قال: كان الرجل ينطلق إلى الكاهن الّذي يوحي إليه الشيطان فيقول: قل للشيطان: فلان قد عاذ بك.
و فيه في قوله تعالى:( فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخافُ بَخْساً وَ لا رَهَقاً ) قال: البخس النقصان، و الرهق العذاب.
و سئل العالم عن مؤمني الجنّ أ يدخلون الجنّة؟ فقال: لا و لكن لله حظائر بين الجنّة و النار يكون فيها مؤمنوا الجنّ و فسّاق الشيعة.
أقول: لعلّ المراد بهذه الحظائر هي بعض درجات الجنّة الّتي هي دون جنّة الصالحين.
و اعلم أنّه ورد في بعض الروايات من طرق أئمّة أهل البيتعليهمالسلام تطبيق ما في الآيات من الهدى و الطريقة على ولاية عليّعليهالسلام و هي من الجري و ليست من التفسير في شيء.
( سورة الجنّ الآيات 18 - 28)
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا ( 18 ) وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ( 19 ) قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ( 20 ) قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ( 21 ) قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ( 22 ) إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ( 23 ) حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ( 24 ) قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ( 25 ) عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ( 26 ) إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ( 27 ) لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ( 28 )
( بيان)
في الآيات تسجيل للنبوّة و ذكر وحدانيّته تعالى و المعاد كالاستنتاج من القصّة و تختتم بالإشارة إلى عصمة الرسالة.
قوله تعالى: ( وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً ) معطوف على قوله:( أَنَّهُ اسْتَمَعَ ) إلخ، و جملة( أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ ) في موضع التعليل لقوله:( فَلا تَدْعُوا مَعَ
اللهِ أَحَداً ) و التقدير لا تدعوا مع الله أحداً غيره لأنّ المساجد له.
و المراد بالدعاء العبادة و قد سمّاها الله دعاء كما في قوله:( وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ ) المؤمن: 60.
و قد اختلف في المراد من المساجد فقيل: المراد به الكعبة، و قيل المسجد الحرام، و قيل: المسجد الحرام و بيت المقدس، و يدفعها كون المساجد جمعاً لا ينطبق على الواحد و الاثنين.
و قيل: الحرم، و هو تهكّم لا دليل عليه، و قيل: الأرض كلّها لقولهصلىاللهعليهوآلهوسلم : جعلت لي الأرض مسجداً و طهوراً، و فيه أنّه لا يدلّ على أزيد من جواز العبادة في أي بقعة من بقاع الأرض خلافاً لما هو المعروف عن اليهود و النصارى من عدم جواز عبادته تعالى في غير البيع و الكنائس، و أمّا تسمية بقاعها مساجد حتّى يحمل عليها عند الإطلاق فلا.
و قيل: المراد به الصلوات فلا يصلّى إلّا لله، و هو تهكّم لا دليل عليه.
و عن الإمام الجوادعليهالسلام : أنّ المراد بالمساجد الأعضاء السبعة الّتي يسجد عليها في الصلاة و هي الجبهة و الكفّان و الركبتان و أصابع الرجلين، و ستوافيك روايته في البحث الروائيّ التالي إن شاء الله، و نقل ذلك أيضاً عن سعيد بن جبير و الفرّاء و الزجّاج.
و الأنسب على هذا أن يكون المراد بكون مواضع السجود من الإنسان لله اختصاصها به اختصاصاً تشريعيّاً، و المراد بالدعاء السجدة لكونها أظهر مصاديق العبادة أو الصلاة بما أنّها تتضمّن السجود لله سبحانه.
و المعنى: و اُوحي إليّ أنّ أعضاء السجود يختصّ بالله تعالى فاسجدوا له بها - أو اعبدوه بها - و لا تسجدوا - أو لا تعبدوا - أحداً غيره.
قوله تعالى: ( وَ أَنَّهُ لَمَّا قامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً ) اللبد بالكسر فالفتح جمع لبدة بالضمّ فالسكون المجتمعة المتراكمة، و المراد بعبد الله النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم
كما تدلّ عليه الآية التالية، و التعبير بعبد الله كالتمهيد لقوله في الآية التالية:( قُلْ إِنَّما أَدْعُوا رَبِّي ) . و الأنسب لسياق الآيات التالية أن يكون مرجع ضميري الجمع في قوله:( كادُوا يَكُونُونَ ) المشركين و قد كانوا يزدحمون عليهصلىاللهعليهوآلهوسلم إذا صلّى و قرأ القرآن يستهزؤن و يرفعون أصواتهم فوق صوته على ما نقل.
و المعنى: و أنّه لما قام النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم يعبد الله بالصلاة كاد المشركون يكونون بازدحامهم لبداً مجتمعين متراكمين.
و قيل: الضميران للجنّ و أنّهم اجتمعوا عليه و تراكموا ينظرون إليه متعجّبين ممّا يشاهدون من عبادته و قراءته قرآناً لم يسمعوا كلاماً يماثله.
و قيل: الضميران للمؤمنين بالنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم المجتمعين عليه اقتداء به في صلاته إذا صلّى و إنصاتاً لما يتلوه من كلام الله.
و الوجهان لا يلائمان سياق الآيات التالية تلك الملاءمة كما تقدّمت الإشارة إليه.
قوله تعالى: ( قُلْ إِنَّما أَدْعُوا رَبِّي وَ لا أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً ) أمر منه تعالى للنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم أن يبيّن لهم وجه عبادته بياناً يزيل عنهم الحيرة حيث رأوا منه ما لم يكونوا رأوه من أحد غيره، و يتعجّبون حاملين له على نوع من المكيدة و المكر بأصنامهم أو خدعة بهم لأغراض اُخر دنيويّة.
و محصّل البيان: أنّي لست اُريد بما آتي به من العمل شيئاً من المقاصد الّتي تحسبونها و ترمونني بها و إنّما أدعو ربّي وحدة غير مشرك به أحداً و عبادة الإنسان لمن عرفه رباً لنفسه ممّا لا ينبغي أن يلام عليه أو يتعجّب منه.
قوله تعالى: ( قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ لا رَشَداً ) الّذي يفيده سياق الآيات الكريمة أنّهصلىاللهعليهوآلهوسلم يبيّن فيها بأمر من ربّه موقع نفسه و بالنسبة إلى ربّه و بالنسبة إلى الناس:
أمّا موقعه بالنسبة إلى ربّه فهو أنّه يدعوه و لا يشرك به أحداً و هو قوله:( قُلْ إِنَّما أَدْعُوا رَبِّي وَ لا أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً ) .
و أمّا موقعه بالنسبة إليهم فهو أنّه بشر مثلهم لا يملك لهم ضرّاً و لا رشداً حتّى يضرّهم بما يريد أن يرشدهم من الخير إلى ما يريد بما عنده من القدرة، و أنّه مأمور من الله بدعوتهم أمراً ليس له إلّا أن يمتثله فلا مجير يجيره منه و لا ملجأ يلتجئ إليه لو خالف و عصى كما ليس لهم إلّا أن يطيعوا الله و رسوله و من يعص الله و رسوله فإنّ له نار جهنّم خالدين فيها أبداً، و سيعلمون إذا رأوا ما يوعدون.
و لازم هذا السياق أن يكون المراد بملك الضرّ القدرة على إيقاع الضرّ بهم فيوقعه بهم إذا أراد، و المراد بملك الرشد القدرة على إيصال النفع إليهم بإصابة الواقع أيّ إنّي لا أدّعي أنّي أقدر أن أضرّكم أو أنفعكم، و قيل: المراد بالضرّ الغيّ المقابل للرشد تعبيراً باسم المسبّب عن السبب.
قوله تعالى: ( قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللهِ أَحَدٌ وَ لَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً إِلَّا بَلاغاً مِنَ اللهِ وَ رِسالاتِهِ ) الإجارة إعطاء الجوار و حكمه حماية المجير للجار و منعه ممّن يقصده بسوء، و الظاهر أنّ الملتحد اسم مكان و هو المكان الّذي يعدل و ينحرف إليه للتحرّز من الشرّ، و قيل: المدخل و يتعلّق به قوله:( مِنْ دُونِهِ ) و هو كالقيد التوضيحيّ و الضمير لله و البلاغ التبليغ.
و قوله:( إِلَّا بَلاغاً ) استثناء من قوله:( مُلْتَحَداً ) و قوله:( مِنَ اللهِ ) متعلّق بمقدّر أي كائناً من الله و ليس متعلّقاً بقوله:( بَلاغاً ) لأنّه يتعدّى بعن لا بمن و لذا قال بعض من جعله متعلّقاً ببلاغاً: إنّ( من ) بمعنى عن، و المعنى على أيّ حال إلّا تبليغ ما هو تعالى عليه من الأسماء و الصفات.
و قوله:( وَ رِسالاتِهِ ) قيل: معطوف على( بَلاغاً ) و التقدير إلّا بلاغاً من الله و إلّا رسالاته و قيل: معطوف على لفظ الجلالة و من بمعنى عن، و المعنى إلّا بلاغاً عن الله و عن رسالاته.
و فيما استثني منه بلاغاً قول آخر و هو أنّه مفعول( لا أَمْلِكُ ) و المعنى لا أملك لكم ضرّاً و لا رشداً إلّا تبليغاً من الله و رسالاته، و يبعّده الفصل بين المستثنى و المستثنى منه بقوله:( لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللهِ أَحَدٌ ) إلخ و هو كلام مستأنف.
و معنى الآيتين على ما قدّمنا: قل لن يجيرني من الله أحد فيمنعني منه و لن أجد من دونه مكاناً التجئ إليه إلّا تبليغاً كائناً منه و رسالاته أي إلّا أن أمتثل ما أمرني به من التبليغ منه تعالى ببيان أسمائه و صفاته و إلّا رسالاته في شرائع الدين.
قوله تعالى: ( وَ مَنْ يَعْصِ اللهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أَبَداً ) إفراد ضمير( اللهِ ) باعتبار لفظ( مِنَ ) كما أنّ جمع( خالِدِينَ ) باعتبار معناها.
و عطف الرسول على الله في قوله:( وَ مَنْ يَعْصِ اللهَ وَ رَسُولَهُ ) لكون معصيته معصية لله تعالى إذ ليس له إلّا رسالة ربّه فالردّ عليه فيما أتي به ردّ على الله سبحانه و طاعته فيما يأمر به طاعة لله قال تعالى:( مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ ) النساء: 80.
و المراد بالمعصية - كما يشهد به سياق الآيات السابقة - معصية ما أمر به من التوحيد أو التوحيد و ما يتفرّع عليه من اُصول الدين و فروعه فلا يشمل التهديد و الوعيد بخلود النار إلّا الكافرين بأصل الدعوة دون مطلق أهل المعصية المتخلّفين عن فروع الدين فالاحتجاج بالآية على تخليد مطلق العصاة في النار في غير محلّه.
و الظاهر أنّ قوله:( وَ مَنْ يَعْصِ اللهَ ) إلى آخر الآية من كلام الله سبحانه لا من تتمّة كلام النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم .
قوله تعالى: ( حَتَّى إِذا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ ناصِراً وَ أَقَلُّ عَدَداً ) لقوله:( حَتَّى ) دلالة على معنى مدخولها غاية له و مدخولها يدلّ على أنّهم كانوا يستضعفون النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم بعدّ ناصريه - و هم المؤمنون - ضعفاء و استقلال عدده بعدّ عددهم قليلاً فالكلام يدلّ على معنى محذوف هو غايته كقولنا: لا يزالون يستضعفون ناصريك و يستقلّون عددهم حتّى إذا رأوا ما يوعدون إلخ.
و المراد بما يوعدون نار جهنّم لأنّها هي الموعودة في الآية، و الآية من كلامه تعالى يخاطب النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم و لو كانت من كلامه و هي مصدّرة بقوله تعالى( قُلْ ) لكان من حقّ الكلام أن يقال: حتّى إذا رأيتم ما توعدون فستعلمون إلخ.
قوله تعالى: ( قُلْ إِنْ أَدْرِي أَ قَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَداً ) الأمد الغاية الّتي ينتهي إليها، و الآية بمنزلة دفع دخل تقتضيه حالهم كأنّهم لمّا سمعوا
الوعيد قالوا: متى يكون ذلك فقيل له:( قُلْ إِنْ أَدْرِي أَ قَرِيبٌ ) إلخ.
قوله تعالى: ( عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً ) إظهار الشيء على الشيء إعانته و تسليطه عليه، و( عالِمُ الْغَيْبِ ) خبر لمبتدإ محذوف، و التقدير هو عالم الغيب، و مفاد الكلمة بإعانة من السياق اختصاص علم الغيب به تعالى مع استيعاب علمه كلّ غيب، و لذا أضاف الغيب إلى نفسه ثانياً فقال:( عَلى غَيْبِهِ ) بوضع الظاهر موضع المضمر ليفيد الاختصاص و لو قال: فلا يظهر عليه لم يفد ذلك.
و المعنى هو عالم كلّ غيب علماً يختصّ به فلا يطلع على الغيب و هو مختصّ به أحداً من الناس فالمفاد سلب كلّي و إن أصرّ بعضهم على كونه سلباً جزئياً محصّل معناه لا يظهر على كلّ غيبه أحداً و يؤيّد ما قلنا ظاهر ما سيأتي من الآيات.
قوله تعالى: ( إِلَّا مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ ) استثناء من قوله:( أَحَداً ) و( مِنْ رَسُولٍ ) بيان لقوله:( مَنِ ارْتَضى ) فيفيد أنّ الله تعالى يظهر رسله على ما شاء من الغيب المختصّ به فالآية إذا انضمّت إلى الآيات الّتي تخصّ علم الغيب به تعالى كقوله:( وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ ) الأنعام: 59، و قوله:( وَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ) النحل: 77، و قوله:( قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ ) النمل: 65 أفاد ذلك معنى الأصالة و التبعيّة فهو تعالى يعلم الغيب لذاته و غيره يعلمه بتعليم من الله.
فهذه الآيات نظيرة الآيات المتعرّضة للتوفّي كقوله:( اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ ) الزمر: 42 الدالّ على الحصر، و قوله:( قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ) الم السجدة: 11، و قوله:( حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا ) الأنعام: 61 فالتوفّي منسوب إليه تعالى على نحو الأصالة و إلى الملائكة على نحو التبعيّة لكونهم أسباباً متوسّطة مسخّرة له تعالى.
قوله تعالى: ( فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً - إلى قوله -عَدَداً ) ضمير( فَإِنَّهُ ) لله تعالى، و ضميراً( يَدَيْهِ ) و( خَلْفِهِ ) للرسول، و الراصد المراقب للأمر الحارس له، و الرصد الراصد يطلق على الواحد و الجماعة و هو في الأصل مصدر،
و المراد بما بين يدي الرسول ما بينه و بين الناس المرسل إليهم، و بما خلفه ما بينه و بين مصدر الوحي الّذي هو الله سبحانه و قد اعتبر في هذا التصوير ما يوهمه معنى الرسالة من امتداد متوهّم يأخذ من المُرسِل - اسم فاعل - و ينتهي إلى المرسل إليه يقطعه الرسول حتّى ينتهي إلى المرسل إليه فيؤدّي رسالته، و الآية تصف طريق بلوغ الغيب إلى الرسول و هو الرسالات الّتي توحي إليه كما يشير إلى ذلك قوله:( لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسالاتِ رَبِّهِمْ ) .
و المعنى: فإنّ الله يسلك ما بين الرسول و من اُرسل إليه و ما بين الرسول و مصدر الوحي مراقبين حارسين من الملائكة - و من المعلوم أنّ سلوك الرصد من بين يديه و من خلفه لحفظ الوحي من كلّ تخليط و تغيير بالزيادة و النقصان يقع فيه من ناحية الشياطين بلا واسطة أو معها.
و قوله:( لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسالاتِ رَبِّهِمْ ) ضمير( لِيَعْلَمَ ) لله سبحانه، و ضميراً( قَدْ أَبْلَغُوا ) و( رَبِّهِمْ ) لقوله:( مَنِ ) باعتبار المعنى أو لرسول باعتبار الجنس، و المراد بعلمه تعالى بإبلاغهم رسالات ربّهم العلم الفعليّ و هو تحقّق الإبلاغ في الخارج على حدّ قوله:( فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ) العنكبوت: 3 و هو كثير الورود في كلامه تعالى.
و الجملة تعليل لسلوك الرصد بين يدي الرسول و من خلفه، و المعنى ليتحقّق إبلاغ رسالات ربّهم أي لتبلغ الناس رسالاته تعالى على ما هي عليه من غير تغيّر و تبدّل.
و من المحتمل أن يرجع ضميراً( بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ ) إلى( غَيْبِهِ ) فيكون الرصد الحرس مسلوكين بين يدي الغيب النازل و من خلفه إلى أن يبلغ الرسول، و يضعّفه أنّه لا يلائم قوله:( لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسالاتِ رَبِّهِمْ ) بالمعنى الّذي تقدّم لعدم استلزام بلوغ الغيب للرسول سليماً من تعرّض الشياطين حصول العلم بإبلاغه إلى الناس.
و إلى هذا المعنى يرجع قول بعضهم إنّ الضميرين يرجعان إلى جبريل حامل
الوحي. و يضعفه مضافاً إلى ما مرّ عدم سبق ذكره.
و قيل: ضمير ليعلم للرسول و ضميراً( قَدْ أَبْلَغُوا ) و( رَبِّهِمْ ) للملائكة الرصد و المعنى يرصد الملائكة الوحي و يحرسونه ليعلم الرسول أنّ الملائكة قد أبلغوا إليه الوحي كما صدر فتطمئنّ نفسه أنّه سليم من تعرّض الشياطين فإنّ لازم العلم بإبلاغهم إيّاه العلم ببلوغه.
و يبعّده أنّ ظاهر السياق - و يؤيّده سبق ذكر الرسول - أنّ المراد بالرسالات الرسالات الّتي حمّلها الرسول ليبلغها إلى الناس لا ما حمّلها ملك الوحي فضمير( رَبِّهِمْ ) للرسل دون الملائكة، على أنّ الآية تشير إلى الملائكة بعنوان الرصد و هو غير عنوان الرسالة و شأن الرصد الحفظ و الحراسة دون الرسالة.
و قيل: المعنى ليعلم محمّدصلىاللهعليهوآلهوسلم أنّ الرسل قبله قد أبلغوا رسالات ربّهم، و هو وجه سخيف لا دليل عليه، و أسخف منه ما قيل: إنّ المعنى ليعلم مكذّب الرسل أنّ الرسل قد أبلغوا رسالات ربّهم إليهم.
و قوله:( وَ أَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ ) ضمير الجمع للرسل بناء على ما تقدّم من المعنى و الظاهر أنّ الجملة متمّمة لمعنى الحراسة المذكورة سابقاً فقوله:( مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ) يشير إلى رصد ما بين الرسول و المرسل إليهم، و قوله:( وَ مِنْ خَلْفِهِ ) إلى حفظ ما بينه و مصدر الوحي، و قوله:( وَ أَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ ) يشير إلى ظرف نفس الرسول و الإحاطة إحاطة علميّة فالوحي في أمن من تطرّق التغيير و التبديل فيما بين مصدر الوحي و الرسول و في نفس الرسول و في ما بين الرسول و المرسل إليهم.
و يمكن أن يكون المراد بما لديهم جميع ما له تعلّق مّا بالرسل أعمّ من مسير الوحي أو أنفسهم كما أنّ قوله:( وَ أَحْصى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً ) مسوق لإفادة عموم العلم بالأشياء غير أنّه العلم بعددها و تميّز بعضها من بعض.
فقد تبيّن ممّا مرّ في الآيات الثلاث:
أوّلاً: أنّ اختصاصه تعالى بعلم الغيب على نحو الأصالة بالمعنى الّذي أوضحناه فهو تعالى يعلم الغيب بذاته و غيره يعلمه بتعليم منه.
و به يظهر أنّ ما حكي في كلامه تعالى من إنكارهم العلم بالغيب اُريد به نفي الأصالة و الاستقلال دون ما كان بوحي كقوله تعالى:( قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللهِ وَ لا أَعْلَمُ الْغَيْبَ ) الأنعام: 50، و قوله:( وَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ) الأعراف: 188 و قوله:( قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَ ما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَ لا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ ) الأحقاف: 9.
و ثانياً: أنّ عموم قوله:( فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً ) لمّا خصّص بقوله:( إِلَّا مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ ) عاد عامّاً مخصّصاً لا يأبى تخصيصاً بمخصّص آخر كما في مورد الأنبياء فإنّ الآيات القرآنيّة تدلّ على أنّهم يوحى إليهم كقوله:( إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلى نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ) النساء: 163 و تدلّ على أنّ الوحي من الغيب فالنبيّ ينال الغيب كما يناله الرسول هذا على تقدير أن يكون المراد بالرسول في الآية ما يقابل النبيّ و أمّا لو اُريد مطلق من أرسله الله إلى الناس و النبيّ ممّن أرسله الله إليهم كما يشهد به قوله:( وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ ) الآية الحجّ: 52، و قوله:( وَ ما أَرْسَلْنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ ) الأعراف: 94 فالنبيّ خارج من عموم النفي من غير تخصيص جديد.
و كذا في مورد الإمام بالمعنى الّذي يستعمله فيه القرآن فإنّه تعالى يصفه بالصبر و اليقين كما في قوله:( وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَ كانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ ) الم السجدة: 24 و يعرّفهم بانكشاف الغطاء لهم كما في قوله:( وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ) الأنعام: 75، و قوله:( كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ) التكاثر: 6 و قد تقدّم كلام في ذلك في بعض المباحث السابقة.
و أمّا الملائكة فما يحمّلونه من الوحي السماويّ قبل نزوله و كذا ما يشاهدونه من عالم الملكوت شهادة بالنسبة إليهم و إن كان غيباً بالنسبة إلينا. على أنّ قوله:( فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً ) إنّما يشمل أهل الدنيا ممّن يعيش على بسيط الأرض و إلّا لانتقض بالأموات المشاهدين لاُمور الآخرة و هي من الغيب بنصّ القرآن فلم
يبق تحت عموم النفي حتّى فرد واحد إذ ما من أحد إلّا و هو مبعوث ذلك يوم مجموع له الناس و ذلك يوم مشهود، و كما أنّ الأموات نشأتهم غير نشأة الدنيا كذلك نشأة الملائكة غير نشأة المادّة.
و ثالثاً: أنّ قوله:( فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ ) إلى آخر الآيتين يدلّ على أنّ الوحي الإلهيّ محفوظ من لدن صدوره من مصدر الوحي إلى بلوغه الناس مصون في طريق نزوله إلى أن يصل إلى من قصد نزوله عليه.
أمّا مصونيّته من حين صدوره من مصدره إلى أن ينتهي إلى الرسول فيكفي في الدلالة عليه قوله:( مِنْ خَلْفِهِ ) (1) و أمّا مصونيّته حين أخذ الرسول إيّاه و تلقّيه من ملك الوحي بحيث يعرفه و لا يغلط في أخذه، و مصونيّته في حفظه بحيث يعيه كما اُوحي إليه من غير أن ينساه أو يغيّره أو يبدّله، و مصونيّته في تبليغه إلى الناس من تصرف الشيطان فيه فالدليل عليه قوله:( لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسالاتِ رَبِّهِمْ ) حيث يدلّ على أنّ الغرض الإلهيّ من سلوك الرصد أن يعلم إبلاغهم رسالات ربّهم أي أن يتحقّق في الخارج إبلاغ الوحي إلى الناس، و لازمه بلوغه إيّاهم و لو لا مصونيّة الرسول في الجهات الثلاث المذكورة جميعاً لم يتمّ الغرض الإلهي و هو ظاهر، و حيث لم يذكر تعالى للحصول على هذا الغرض طريقاً غير سلوك الرصد دلّ ذلك على أنّ الوحي محروس بالملائكة و هو عند الرسول كما أنّه محروس بهم في طريقه إلى الرسول حتّى ينتهي إليه، و يؤكّده قوله بعد:( وَ أَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ ) .
و أمّا مصونيّته في مسيره من الرسول حتّى ينتهي إلى الناس فيكفي فيه قوله:( مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ) على ما تقدّم من معناه.
أضف إلى ذلك دلالة قوله:( لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسالاتِ رَبِّهِمْ ) بما تقدّم من تقريب دلالته.
____________________
(1) هذا بناء على رجوع الضمير إلى الرسول و أمّا بناء على احتمال رجوع الضمير إلى الغيب فالدالّ عليه مجموع ( مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ ) لكنه ضعيف كما تقدم.
و يتفرّع على هذا البيان أنّ الرسول مؤيّد بالعصمة في أخذ الوحي من ربّه و في حفظه و في تبليغه إلى الناس مصون من الخطإ في الجهات الثلاث جميعاً لما مرّ من دلالة الآية على أنّ ما نزّله الله من دينه على الناس من طريق الرسالة بالوحي مصون في جميع مراحله إلى أن ينتهي إلى الناس و من مراحله مرحلة أخذ الرسول للوحي و حفظه له و تبليغه إلى الناس.
و التبليغ يعمّ القول و الفعل فإنّ في الفعل تبليغاً كما في القول فالرسول معصوم من المعصية باقتراف المحرّمات و ترك الواجبات الدينيّة لأنّ في ذلك تبليغاً لما يناقض الدين فهو معصوم من فعل المعصية كما أنّه معصوم من الخطإ في أخذ الوحي و حفظه و تبليغه قولاً.
و قد تقدّمت الإشارة إلى أنّ النبوّة كالرسالة في دورانها مدار الوحي فالنبيّ كالرسول في خاصّة العصمة، و يتحصّل بذلك أنّ أصحاب الوحي سواء كانوا رسلاً أو أنبياء معصومون في أخذ الوحي و في حفظ ما اُوحي إليهم و في تبليغه إلى الناس قولاً و فعلاً.
و رابعاً: أنّ الّذي استثني في الآية من الإظهار على الغيب إظهار الرسول على ما يتوقّف عليه تحقّق إبلاغ رسالته أعمّ من أن يكون متن الرسالة كالمعارف الاعتقادية و شرائع الدين و القصص و العبر و الحكم و المواعظ أو يكون من آيات الرسالة و المعجزات الدالّة على صدق الرسول في دعواه كالّذي حكي عن بعض الرسل من الإخبار بالمغيّبات كقول صالح لقومه:( تَمَتَّعُوا فِي دارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ذلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ) هود: 65، و قول عيسى لبني إسرائيل:( وَ أُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ ) آل عمران: 49، و كذا ما ورد من مواعد الرسل، و ما ورد في الكتاب العزيز من الملاحم كلّ ذلك من إظهارهم على الغيب.
( بحث روائي)
عن تفسير العيّاشيّ، عن أبي جعفرعليهالسلام : أنّه سأله المعتصم عن السارق من أيّ موضع يجب أن يقطع؟ فقال: إنّ القطع يجب أن يكون من مفصل اُصول الأصابع فتترك الكفّ.
فقال: و ما الحجّة في ذلك؟ قال: قول رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : السجود على سبعة أجزاء: الوجه و اليدين و الركبتين و الرجلين فإذا قطع من الكرسوع أو المرفق لم يدع له يداً يسجد عليها و قال الله:( وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ ) يعني به هذه الأعضاء السبعة الّتي يسجد عليها( فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً ) و ما كان لله فلا يقطع. الحديث.
و في الكافي، بإسناده عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبداللهعليهالسلام في حديث: و سجد يعني أباعبداللهعليهالسلام على ثمانية أعظم: الكفّين و الركبتين و إبهامي الرجلين و الجبهة و الأنف، و قال: سبعة منها فرض يسجد عليها و هي الّتي ذكرها الله في كتابه فقال:( وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً ) و هي الجبهة و الكفّان و الركبتان و الإبهامان و وضع الأنف على الأرض سنّة.
و عن الخرائج و الجرائح، روى محمّد بن الفضل الهاشميّ عن الرضاعليهالسلام : أنّه نظر إلى ابن هذاب فقال: إن أنا أخبرتك أنّك ستبتلى في هذه الأيّام بدم ذي رحم لك لكنت مصدّقاً لي؟ قال: لا فإنّ الغيب لا يعلمه إلّا الله تعالى. قال: أ و ليس أنّه يقول:( عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ ) فرسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم عند الله مرتضى، و نحن ورثة ذلك الرسول الّذي أطلعه الله على ما يشاء من غيبه فعلمنا ما كان و ما يكون إلى يوم القيامة.
أقول: و الأخبار في هذا الباب فوق حدّ الإحصاء، و مدلولها أنّ النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم أخذه بوحي من ربّه و أنّهم أخذوه بالوراثة منهصلىاللهعليهوآلهوسلم .
( سورة المزّمّل مكّيّة و هي عشرون آية)
( سورة المزّمّل الآيات 1 - 19)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ( 1 ) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ( 2 ) نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ( 3 ) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ( 4 ) إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ( 5 ) إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ( 6 ) إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ( 7 ) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ( 8 ) رَّبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ( 9 ) وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ( 10 ) وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ( 11 ) إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا ( 12 ) وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ( 13 ) يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ( 14 ) إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ( 15 ) فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ( 16 ) فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ( 17 ) السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ( 18 ) إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ( 19 )
( بيان)
السورة تأمر النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم بقيام الليل و الصلاة فيه ليستعدّ بذلك لتلقّي ثقل ما سيلقى عليه من القول الثقيل و القرآن الموحي إليه، و تأمره أن يصبر على ما يقولون فيه إنّه شاعر أو كاهن أو مجنون إلى غير ذلك و يهجرهم هجراً جميلاً، و فيها وعيد و إنذار للكفّار و تعميم الحكم لسائر المؤمنين، و في آخرها تخفيف مّا للنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم و المؤمنين.
و السورة مكّيّة من عتائق السور النازلة في أوّل البعثة حتّى قيل: إنّها ثانية السور النازلة على النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم أو ثالثتها.
قوله تعالى: ( يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ) بتشديد الزاي و الميم و أصله المتزمّل اسم فاعل من التزمّل بمعنى التلفّف بالثوب لنوم و نحوه، و ظاهره أنّهصلىاللهعليهوآلهوسلم كان قد تزمّل بثوب للنوم فنزل عليه الوحي و خوطب بالمزمّل.
و ليس في الخطاب به تهجين و لا تحسين كما توهّمه بعضهم، نعم يمكن أن يستفاد من سياق الآيات أنّهصلىاللهعليهوآلهوسلم كان قد قوبل في دعوته بالهزء و السخريّة و الإيذاء فاغتمّ في الله فتزمّل بثوب لينام دفعاً للهمّ فخوطب بالمزّمّل و اُمر بقيام الليل و الصلاة فيه و الصبر على ما يقولون على حدّ قوله تعالى:( اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ ) البقرة: 153 فاُفيد بذلك أنّ عليه أن يقاوم الكرب العظام و النوائب المرّة بالصلاة و الصبر لا بالتزمّل و النوم.
و قيل: المراد يا أيّها المتزمّل بعباءة النبوّة أي المتحمّل لأثقالها، و لا شاهد عليه من جهة اللفظ.
قوله تعالى: ( قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ) المراد بقيام اللّيل القيام فيه إلى الصلاة فالليل مفعول به توسعاً كما في قولهم: دخلت الدار، و قيل: معمول( قُمِ ) مقدّر و( اللَّيْلَ ) منصوب على الظرفيّة و التقدير قم إلى الصلاة في الليل، و قوله:( إِلَّا قَلِيلًا ) استثناء من الليل.
و قوله:( نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ ) ظاهر السياق أنّه بدل من( اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ) المتعلّق به تكليف القيام، و ضميراً( مِنْهُ ) و( عَلَيْهِ) للنصف، و ضمير( نِصْفَهُ ) للّيل، و المعنى قم نصف الليل أو انقص من النصف قليلاً أو زد على النصف قليلاً، و الترديد بين الثلاثة للتخيير فقد خيّر بين قيام النصف و قيام أقلّ من النصف بقليل و قيام أكثر منه بقليل.
و قيل:( نِصْفَهُ ) بدل من المستثنى أعني( قَلِيلًا ) فيكون المعنى قم الليل إلّا نصفه أو انقص من النصف قليلا فقم أكثر من النصف بقليل أو زد على النصف فقم أقلّ من النصف، و تكون جملة البدل رافعاً لإبهام المستثنى بالمطابقة و لإبهام المستثنى منه بالالتزام عكس الوجه السابق.
و الوجهان و إن اتّحداً في النتيجة غير أنّ الوجه السابق أسبق إلى الذهن لأنّ الحاجة إلى رفع الإبهام عن متعلّق الحكم أقدم من الحاجة إلى رفع الإبهام عن توابعه و ملحقاته فكون قوله:( نصفه ) إلخ بدلاً من الليل و لازمه رفع إبهام متعلّق التكليف بالمطابقة أسبق إلى الذهن من كونه بدلاً من( قَلِيلًا ) .
و قيل: إنّ نصفه بدل من الليل لكنّ المراد بالقليل القليل من الليالي دون القليل من أجزاء الليل، و المعنى قم نصف الليل أو انقص منه قليلاً أو زد عليه إلّا قليلاً من الليالي و هي ليالي العذر من مرض أو غلبة نوم أو نحو ذلك، و لا بأس بهذا الوجه لكنّ الوجه الأوّل أسبق منه إلى الذهن.
و قوله:( وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ) ترتيل القرآن تلاوته بتبيين حروفه على تواليها، و الجملة معطوفة على قوله:( قُمِ اللَّيْلَ ) أي قم الليل و اقرأ القرآن بترتيل.
و الظاهر أنّ المراد بترتيل القرآن ترتيله في الصلاة أو المراد به الصلاة نفسها و قد عبّر سبحانه عن الصلاة بنظير هذا التعبير في قوله:( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً ) إسراء: 78، و قيل: المراد إيجاب قراءة القرآن دون الصلاة.
قوله تعالى: ( إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ) الثقل كيفيّة جسمانيّة من خاصّته أنّه يشقّ حمل الجسم الثقيل و نقله من مكان إلى مكان و ربّما يستعار للمعاني إذا شقّ على النفس تحمّلها أو لم تطقها فربّما اُضيف إلى القول من جهة معناه فعدّ ثقيلاً لتضمّنه معنى يشقّ على النفس إدراكه أو لا تطيق فهمه أو تتحرّج من تلقّيه كدقائق الأنظار العلميّة إذا اُلقيت على الأفهام العامّة، أو لتضمّنه حقائق يصعب التحقّق بها أو تكاليف يشقّ الإتيان بها و المداومة عليها.
و القرآن قول إلهيّ ثقيل بكلا المعنيين: أمّا من حيث تلقّي معناه فإنّه كلام إلهي مأخوذ من ساحة العظمة و الكبرياء لا تتلقّاه إلّا نفس طاهرة من كلّ دنس منقطع عن كلّ سبب إلّا الله سبحانه، و كتاب عزيز له ظهر و بطن و تنزيل و تأويل تبياناً لكلّ شيء، و قد كان ثقله مشهوداً من حال النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم بما كان يأخذه من البرحاء و شبه الإغماء على ما وردت به الأخبار المستفيضة.
و أمّا من حيث التحقّق بحقيقة التوحيد و ما يتبعها من الحقائق الاعتقاديّة فكفى في الإشارة إلى ثقله قوله تعالى:( لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَ تِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ) الحشر: 21، و قوله تعالى:( وَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى ) الرعد: 31.
و أمّا من حيث القيام بما يشتمل عليه من أمر الدعوة و إقامة مراسم الدين الحنيف، و إظهاره على الدين كلّه فيشهد به ما لقيصلىاللهعليهوآلهوسلم من المصائب و المحن في سبيل الله و الأذى في جنب الله على ما يشهد به الآيات القرآنيّة الحاكية لما لقيه النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم من المشركين و الكفّار و المنافقين و الّذين في قلوبهم مرض من أنواع الإيذاء و الهزء و الجفاء.
فقوله:( إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ) المراد بالقول الثقيل القرآن العظيم على ما يسبق إلى الذهن من سياق هذه الآيات النازلة في أوّل البعثة، و به فسّره المفسّرون.
و الآية في مقام التعليل للحكم المدلول عليه بقوله:( قُمِ اللَّيْلَ ) إلخ فتفيد بمقتضى السياق - و الخطاب خاصّ بالنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم - أنّ أمره بقيام الليل و التوجّه فيه إليه تعالى بصلاة اللّيل تهيئة له و إعداد لكرامة القرب و شرف الحضور و إلقاء قول ثقيل فقيام الليل هي السبيل المؤدّية إلى هذا الموقف الكريم و قد عدّ سبحانه صلاة الليل سبيلاً إليه في قوله الآتي:( إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلًا ) .
و قد زاد سبحانه وعداً على ما في هذه الآية في قوله:( وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً ) إسراء: 79 و قد تقدّم معنى المقام المحمود في تفسير الآية.
و إذ كان من ثقل القرآن ثقله من حيث التحقّق بحقائقه و من حيث استجابته فيما يندب إليه من الشرائع و الأحكام فهو ثقيل على الاُمّة كما هو ثقيل عليهصلىاللهعليهوآلهوسلم و معنى الآية إنّا سنوحي إليك قولاً يثقل عليك و على اُمّتك أمّا ثقله عليهصلىاللهعليهوآلهوسلم فلمّا في التحقّق بحقائقه من الصعوبة و لما فيه من محنة الرسالة و ما يتبعها من الأذى في جنب الله و ترك الراحة و الدعة و مجاهدة النفس و الانقطاع إلى الله مضافاً إلى ما في تلقّيه من مصدر الوحي من الجهد، و أمّا ثقله على اُمّته فلأنّهم يشاركونهصلىاللهعليهوآلهوسلم في لزوم التحقّق بحقائقه و اتّباع أوامره و نواهيه و رعاية حدوده كلّ طائفة منهم على قدر طاقته.
و للقوم في معنى ثقل القرآن أقوال اُخر:
منها: أنّه ثقيل بمعنى أنّه عظيم الشأن متين رصين كما يقال: هذا كلام له وزن إذا كان واقعاً موقعه.
و منها: أنّه ثقيل في الميزان يوم القيامة حقيقة أو مجازاً بمعنى كثرة الثواب عليه.
و منها: أنّه ثقيل على الكفّار و المنافقين بما له من الإعجاز و بما فيه من الوعيد.
و منها: أنّ ثقله كناية عن بقائه على وجه الدهر لأنّ الثقيل من شأنه أن يبقى و يثبت في مكانه.
و منها: غير ذلك و الوجوه المذكورة و إن كانت لا بأس بها في نفسها لكن ما تقدّم
من الوجه هو الظاهر السابق إلى الذهن.
قوله تعالى: ( إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهارِ سَبْحاً طَوِيلًا ) الآية الاُولى في مقام التعليل لاختيار الليل وقتاً لهذه الصلاة، و الآية الثانية في مقام التعليل لترك النهار و الإعراض عنه كما أنّ الآية السابقة أعني قوله:( إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ) في مقام التعليل لتشريع أصل هذه الصلاة.
فقوله:( إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِيلًا ) الناشئة إمّا مصدر كالعاقبة و العافية بمعنى النشأة و هي الحدوث و التكوّن، و إمّا اسم فاعل من النشأة مضاف إلى موصوفه و كيف كان فالمراد بها الليل و إطلاق الحادثة على الليل كإطلاقها على سائر أجزاء الخلقة و ربّما قيل: إنها الصلاة في الليل و وطؤ الأرض وضع القدم عليها، و كونها أشدّ وطأ كناية عن كونها أثبت قدماً لصفاء النفس و عدم تكدّرها بالشواغل النهارية و قيل: الوطء مواطاة القلب اللسان و اُيّد بقراءة( أَشَدُّ وَطْئاً ) و المراد بكونها أقوم قيلاً كونها أثبت قولاً و أصوب لحضور القلب و هدوّ الأصوات.
و المعنى إنّ حادثة الليل أو الصلاة في الليل هي أثبت قدماً - أو أشدّ في مواطاة القلب اللسان و أثبت قولاً و أصوب لما أنّ الله جعل الليل سكنا يستتبع انقطاع الإنسان عن شواغل المعيشة إلى نفسه و فراغ باله.
و قوله:( إِنَّ لَكَ فِي النَّهارِ سَبْحاً طَوِيلًا ) السبح المشي السريع في الماء و السبح الطويل في النهار كناية عن الغور في مهمّات المعاش و أنواع التقلّب في قضاء حوائج الحياة.
و المعنى إنّ لك في النهار مشاغل كثيرة تشتغل بها مستوعبة لا تدع لك فراغاً تشتغل فيه بالتوجّه التامّ إلى ربّك و الانقطاع إليه بذكره فعليك بالليل و الصلاة فيه.
و قيل: المعنى إنّ لك في النهار فراغاً لنومك و تدبير أمر معاشك و التصرّف في حوائجك فتهجّد في الليل.
و قيل: المعنى إنّ لك في النهار فراغاً فإن فاتك من الليل شيء أمكنك أن تتداركه في النهار و تقضيه فيه فالآية في معنى قوله:( وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ
خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً ) الفرقان: 62.
و الّذي قدّمناه من المعنى أنسب للمقام.
قوله تعالى: ( وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ) الظاهر أنّه يصف صلاة الليل فهو كالعطف التفسيريّ على قوله:( وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ) و على هذا فالمراد بذكر اسم الربّ تعالى الذكر اللفظي بمواطاة من القلب و كذا المراد بالتبتّل التبتّل مع اللّفظ.
و قيل: الآية تعميم بعد التخصيص و المراد بالذكر دوام ذكره تعالى ليلاً و نهاراً على أيّ وجه كان من تسبيح و تحميد و صلاة و قراءة قرآن و غير ذلك، و إنّما فسّر الذكر بالدوام لأنهصلىاللهعليهوآلهوسلم لم ينسه تعالى حتّى يؤمر بذكره، و المراد الدوام العرفيّ دون الحقيقيّ لعدم إمكانه. انتهى.
و فيه أنّه إن أراد بالذكر الذكر اللفظيّ فعدم نسيانهصلىاللهعليهوآلهوسلم ربّه تعالى لا ينافي أمره بالذكر اللفظي، و إن أراد ما يعمّ الذكر القلبيّ فهو ممنوع و لو سلّم ففيه أوّلاً أنّ عدم نسيانهصلىاللهعليهوآلهوسلم ربّه إلى حين الخطاب لا ينافي أمره بذكره بعده و ثانياً أنّ عدّه الدوام الحقيقيّ غير ممكن و حمل الدوام على العرفيّ وهم ناش عن عدم تحصيل المعنى على ما هو عليه فالله جلّ ذكره مذكور للإنسان لا يغيب عنه و لا لحظة سواء تنبّه عليه الإنسان أو غفل عنه. و من الممكن أن يعرّفه الله نفسه بحيث لا يغفل عنه و لا في حال قال تعالى:( فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ هُمْ لا يَسْأَمُونَ ) حم السجدة: 38 و قال:( يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ لا يَفْتُرُونَ ) الأنبياء: 20 و قد تقدّم في تفسير الآيتين و آخر سورة الأعراف أنّ ذلك لا يختصّ بالملائكة.
و بالجملة قوله:( وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ ) أمر بذكر اسم من أسمائه أو لفظ الجلالة خاصّة و قيل: المراد به البسملة.
و في قوله:( رَبِّكَ ) التفات عن التكلّم مع الغير في قوله:( إِنَّا سَنُلْقِي ) إلى الغيبة و لعلّ الوجه فيه إيقاظ ذلّة العبوديّة الّتي هي الرابطة بين العبد و ربّه،
بذكر صفة الربوبيّة.
و قوله:( وَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ) فسّر التبتّل بالانقطاع أي و انقطع إلى الله، و من المرويّ عن أئمّة أهل البيتعليهمالسلام أنّ التبتّل رفع اليد إلى الله و التضرّع إليه، و هذا المعنى أنسب بناء على حمل الذكر على الذكر اللفظيّ كما تقدّم.
و( تَبْتِيلًا ) مفعول مطلق ظاهراً و كان مقتضى الظاهر أن يقال: و تبتّل إليه تبتّلاً فالعدول إلى التبتيل قيل: لتضمين تبتّل معنى بتّل، و المعنى و قطّع نفسك من غيره إليه تقطيعاً أو احمل نفسك على رفع اليد إليه و التضرّع حملاً، و قيل: لمراعاة الفواصل.
قوله تعالى: ( رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ) وصف مقطوع عن الوصفيّة و التقدير هو ربّ المشرق و المغرب، و ربّ المشرق و المغرب في معنى ربّ العالم كلّه فإنّ المشرق و المغرب جهتان نسبيّتان تشملان جهات العالم المشهود كلّها، و إنّما اختصّاً بالذكر لمناسبة ما تقدّم من ذكر الليل و النهار المرتبطين بالشروق و الغروب.
و إنّما لم يقتصر في الإشارة إلى ربوبيّته تعالى بقوله السابق:( رَبِّكَ ) للإيذان بأنّهصلىاللهعليهوآلهوسلم مأمور باتّخاذه ربّاً لأنّه ربّه و ربّ العالم كلّه لا لأنّه ربّه وحده كما ربّما كان الرجل من الوثنيّين يتّخذ صنماً لنفسه فحسب غير ما اتّخذه غيره من الأصنام و لو كان اتّخاذهصلىاللهعليهوآلهوسلم له تعالى ربّاً من هذا القبيل أو احتمل ذلك لم تصحّ دعوته إلى التوحيد.
و ليكون قوله:( رَبِّكَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ ) - و هو في معنى ربّ العالم كلّه - توطئة و تمهيداً لقوله بعده:( لا إِلهَ إِلَّا هُوَ ) يعلّل به توحيد الاُلوهيّة فإنّ الاُلوهيّة و هي المعبوديّة من فروع الربوبيّة الّتي هي الملك و التدبير كما تقدّم مراراً فهو تعالى الإله وحده لا إله إلّا هو لأنّه الربّ وحده لا ربّ إلّا هو.
و قوله:( فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ) أي في جميع اُمورك، و توكيل الوكيل هو إقامة الإنسان غيره مقام نفسه بحيث تقوم إرادته مقام إرادته و عمله مقام عمله فاتّخاذه تعالى
وكيلاً أن يرى الإنسان الأمر كلّه له و إليه تعالى أمّا في الاُمور الخارجيّة و الحوادث الكونيّة فأن لا يرى لنفسه و لا لشيء من الأسباب الظاهريّة استقلالاً في التأثير فلا مؤثّر في الوجود بحقيقة معنى التأثير إلّا الله فلا يتعلّق بتأثير سبب من الأسباب برضىّ أو سخط أو سرور أو أسف و غير ذلك بل يتوسّل إلى مقاصده و مآربه بما عرّفه الله من الأسباب من غير أن يطمئنّ إلى استقلالها في التأثير و يرجع الظفر بالمطلوب إلى الله ليختار له ما يرتضيه.
و أمّا الاُمور الّتي لها تعلّق بالعمل من العبادات و المعاملات فأن يجعل إرادته تابعة لإرادة ربّه التشريعيّة فيعمل على حسب ما يريده الله تعالى منه فيما شرّع من الشريعة.
و من هنا يظهر أنّ لقوله:( فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ) ارتباطاً بقوله:( وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ ) إلخ و ما تقدّم عليه من الأوامر التشريعيّة كما أنّ له ارتباطاً بما تأخّر عنه من قوله( وَ اصْبِرْ ) و قوله( اهْجُرْهُمْ ) و قوله:( وَ ذَرْنِي ) .
قوله تعالى: ( وَ اصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلًا ) معطوف هو و ما بعده على مدخول الفاء في قوله:( فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًاًا ) فالمعنى اتّخذه وكيلاً و لازم اتّخاذه وكيلاً أن تصبر على ما يقولون ممّا فيه إيذاؤك و الاستهزاء بك و رميك بما ليس فيك كقولهم: افترى على الله، كاهن شاعر، مجنون، أساطير الأوّلين و غير ذلك ممّا يقصّه القرآن.
و أن تهجرهم هجراً جميلاً، و المراد بالهجر الجميل على ما يعطيه السياق أن يعاملهم بحسن الخلق و الدعوة إلى الحقّ بالمناصحة، و لا يواجه قولهم بما في وسعه من المقابلة بالمثل، و الآية لا تدافع آية القتال فلا وجه لقول من قال: إنّها منسوخة بآية القتال.
قوله تعالى: ( وَ ذَرْنِي وَ الْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَ مَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ) تهديد للكفّار يقال: دعني و فلاناً و ذرني و فلاناً أي لا تحل بيني و بينه حتّى أنتقم منه.
و المراد بالمكذّبين اُولي النعمة الكفّار المذكورون في الآية السابقة أو رؤساؤهم
المتبوعون، و الجمع بين توصيفهم بالمكذّبين و توصيفهم باُولي النعمة للإشارة إلى علّة ما يهدّدهم به من العذاب فإنّ تكذيبهم بالدعوة الإلهيّة و هم متنعّمون بنعمة ربّهم كفران منهم بالنعمة و جزاء الكفران سلب النعمة و تبديلها من النقمة.
و المراد بالقليل الّذي يمهّلونه الزمان القليل الّذي يمكثون في الأرض حتّى يرجعوا إلى ربّهم فيحاسبهم و يجازيهم قال تعالى:( إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَ نَراهُ قَرِيباً ) المعارج: 7، و قال:( مَتاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمِهادُ ) آل عمران: 197.
و الآية بظاهرها عامّة، و قيل: وعيد لهم بوقعة بدر و ليس بظاهر، و في الآية التفات عن الغيبة في( رَبِّكَ ) إلى التكلّم وحده في( ذَرْنِي ) و لعلّ الوجه فيه تشديد التهديد بنسبة الأمر إليه سبحانه نفسه ثمّ التفت في قوله:( إِنَّ لَدَيْنا ) إلى التكلّم مع الغير للدلالة على العظمة.
قوله تعالى: ( إِنَّ لَدَيْنا أَنْكالًا وَ جَحِيماً ) تعليل لقوله:( ذَرْنِي ) إلخ و الأنكال القيود، قال الراغب يقال: نكل عن الشيء ضعف و عجز، و نكلته قيّدته و النكل - بالكسر فالسكون - قيد الدابّة و حديدة اللجام لكونهما مانعين، و الجمع الأنكال انتهى، و قال: الجحمة شدّة تأجّج النار و منه الجحيم، انتهى.
قوله تعالى: ( وَ طَعاماً ذا غُصَّةٍ وَ عَذاباً أَلِيماً ) قال في المجمع: الغصّة تردّد اللقمة في الحلق و لا يسيغها آكلها يقال: غصّ بريقه يغصّ غصصاً، و في قلبه غصّة من كذا و هي كاللدغة الّتي لا يسوغ معها الطعام و الشراب، انتهى.
و الآيتان تذكران نقم الآخرة الّتي بدّلت منها نعم الدنيا جزاء لكفرانهم بنعم الله.
قوله تعالى: ( يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَ الْجِبالُ وَ كانَتِ الْجِبالُ كَثِيباً مَهِيلًا ) ظرف للعذاب الموعود في الآيتين السابقتين، قال الراغب: الرجف الاضطراب الشديد يقال: رجفت الأرض و البحر انتهى. و في المجمع: الكثيب الرمل المجتمع الكثير، و هلت أهيله هيلاً فهو مهيل إذا حرّك أسفله فسال أعلاه انتهى، و المعنى ظاهر.
قوله تعالى: ( إِنَّا أَرْسَلْنا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شاهِداً عَلَيْكُمْ كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ) إنذار للمكذّبين اُولي النعمة من قومهصلىاللهعليهوآلهوسلم بعد ما أوعد مطلق المكذّبين اُولي النعمة بما أعدّ لهم من العذاب يوم القيامة بقياس حالهم إلى حال فرعون المستكبر على الله و رسوله المستذلّ لرسول الله و من آمن معه من قومه ثمّ قرع أسماعهم بما انتهى إليه أمر فرعون من أخذ الله له أخذاً وبيلاً فليتّعظوا و ليأخذوا حذرهم.
و في الآية التفات عن الغيبة إلى الخطاب كأنّ المتكلّم لما أوعدهم بالعذاب على الغيبة هاج به الوجد على اُولئك المكذّبين بما يلقون أنفسهم بأيديهم إلى الهلاك الأبديّ لسفاهة رأيهم فشافههم بالإنذار ليرتفع عن أنفسهم أيّ شكّ و ترديد و تتمّ عليهم الحجّة و لعلّهم يتّقون، و لذا عقّب قياسهم إلى فرعون و قياس النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم إلى موسىعليهالسلام و الإشارة إلى عقابه أمر فرعون بقوله( فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً ) إلخ.
فقوله:( إِنَّا أَرْسَلْنا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شاهِداً عَلَيْكُمْ) إشارة إلى تصديق رسالة النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم من قبله تعالى و شهادته على أعمالهم بتحمّلها في الدنيا و تأديتها يوم القيامة، و قد تقدّم البحث عن معنى شهادة الأعمال في الآيات المشتملة عليها مراراً، و في الإشارة إلى شهادتهصلىاللهعليهوآلهوسلم نوع زجر لهم عن عصيانه و مخالفته و تكذيبه.
و قوله:( كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ) هو موسى بن عمرانعليهالسلام .
قوله تعالى: ( فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْناهُ أَخْذاً وَبِيلًا ) أي شديداً ثقيلاً. إشارة إلى عاقبة أمر فرعون في عصيانه موسىعليهالسلام ، و في التعبير عن موسى بالرسول إشارة إلى أنّ السبب الموجب لأخذ فرعون مخالفته أمر رسالته لا نفس موسى بما أنّه موسى، و إذا كان السبب هو مخالفة الرسالة فليحذروا مخالفة رسالة محمّدصلىاللهعليهوآلهوسلم .
كما أنّ وضع الظاهر موضع الضمير في قوله:( فَعَصى فِرْعَوْنُ ) للإيماء إلى أنّ ما كان له من العزّة و العلوّ في الأرض و التبجّح بكثرة العدّة و سعة المملكة و نفوذ المشيّة لم يغن عنه شيئاً و لم يدفع عنه عذاب الله فما الظنّ بهؤلاء المكذّبين؟ و هم كما قال الله:( جُنْدٌ ما هُنالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزابِ ) ص: 11.
قوله تعالى: ( فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِيباً ) نسبة الاتّقاء إلى اليوم من المجاز العقليّ و المراد اتّقاء العذاب الموعود فيه، و عليه فيوماً مفعول به لتتّقون، و قيل: مفعول( تَتَّقُونَ ) محذوف و( يَوْماً ) ظرف له و التقدير فكيف تتّقون العذاب الكائن في يوم، و قيل: المفعول محذوف و( يَوْماً ) ظرف للاتّقاء و قيل غير ذلك.
و قوله:( يَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِيباً ) الشيب جمع أشيب مقابل الشابّ، و جعل الولدان شيباً كناية عن شدّة اليوم لا عن طوله.
قوله تعالى: ( السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ) إشارة بعد إشارة إلى شدّة اليوم، و الانفطار الانشقاق و تذكير الصفة لكون السماء جائز الوجهين يذكّر و يؤنّث، و ضمير( بِهِ ) لليوم، و الباء بمعنى في أو للسببيّة، و المعنى السماء منشقّة في ذلك اليوم أو بسبب ذلك اليوم أي بسبب شدّته.
و قوله:( كانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ) استئناف لتسجيل ما تقدّم من الوعيد و أنّه حتم مقضيّ و نسبة الوعد إلى ضميره تعالى لعلّه للإشعار بأن لا يصلح لهذا الوعد إلّا الله تعالى فيكفي فيه الضمير من غير حاجة إلى ذكره باسمه.
قوله تعالى: ( إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلًا ) الإشارة بهذه إلى الآيات السابقة بما تشتمل عليه من القوارع و الزواجر، و التذكرة الموعظة الّتي يذكر بها ما يعمل عليه.
و قوله:( فَمَنْ شاءَ ) مفعول( شاءَ ) محذوف و المعروف في مثل هذا المورد أن يقدّر المفعول من جنس الجواب و السياق يلائمه، و التقدير فمن شاء أن يتّخذ إلى ربّه سبيلاً اتّخذ إلخ، و قيل: المقدّر الاتّعاظ، و المراد باتّخاذ السبيل إليه اتّخاذ السبيل إلى التقرّب منه، و السبيل هو الإيمان و الطاعة هذا ما ذكره المفسّرون.
و من الممكن أن تكون هذه إشارة إلى ما تقدّم في صدر السورة من الآيات النادبة إلى قيام الليل و التهجّد فيه، و الآية مسوقة لتوسعة الخطاب و تعميمه لغير النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم من المؤمنين بعد ما كان خطاب صدر الصورة مختصّاً بهصلىاللهعليهوآلهوسلم ،
و الدليل على هذا التعميم قوله:( فَمَنْ شاءَ ) إلخ.
و يؤيّد ما ذكرنا وقوع هذه الآية( إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ ) إلخ بعينها في سورة الدهر بعد ما اُشير إلى صلاة الليل بقوله تعالى:( وَ سَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ) و يستنتج من ذلك أنّ صلاة الليل سبيل خاصّة تهدي العبد إلى ربّه.
( بحث روائي)
في الدرّ المنثور، أخرج البزّار و الطبرانيّ في الأوسط و أبونعيم في الدلائل عن جابر قال: اجتمعت قريش في دار الندوة فقالوا: سمّوا هذا الرجل اسماً يصدر الناس عنه فقالوا: كاهن. قالوا ليس بكاهن. قالوا: مجنون. قالوا: ليس بمجنون. قالوا ساحر. قالوا: ليس بساحر. قالوا: يفرّق بين الحبيب و حبيبه فتفرّق المشركون على ذلك.
فبلغ ذلك النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم فتزمّل في ثيابه و تدثّر فيها فأتاه جبريل فقال: يا أيّها المزّمّل يا أيّها المدّثّر.
أقول: آخر الرواية لا يخلو من شيء حيث إنّ ظاهرها نزول السورتين معاً. على أنّ القرآن حتّى في سورة المدّثّر يحكي تسميتهم لهصلىاللهعليهوآلهوسلم بألقاب السوء كالكاهن و الساحر و المجنون و الشاعر و لم يذكر فيها قولهم: يفرّق بين الحبيب و حبيبه.
و فيه، أخرج عبدالله بن أحمد في كتاب الزهد و محمّد بن نصر في كتاب الصلاة عن عائشة قالت: كان النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم قلّما ينام من الليل لما قال الله له:( قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ) .
و في الكشّاف، عن عائشة: أنّها سألت: ما كان تزميله؟ قالت: كان مرطاً طوله أربع عشرة ذراعاً نصفه عليّ و أنا نائمة و نصفه عليه و هو يصلّي. فسئلت: ما كان؟ قالت: و الله ما كان خزّاً و لا قزّاً و لا مرعزّيّاً و لا إبريسماً و لا صوفاً. كان سداه شعراً و لحمته وبراً.
أقول: الرواية مرمية بالوضع فإنّ السورة من العتائق النازلة بمكّة، و عائشة إنّما بنى عليها النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم بالمدينة بعد الهجرة.
و عن جوامع الجامع، روي: أنّه قد دخل على خديجة و قد جئث فرقاً(1) فقال: زمّلوني فبينا هو على ذلك إذ ناداه جبريل:( يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ) .
و في الدرّ المنثور، أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: لمّا نزلت( يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ) مكث النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم على هذه الحال عشر سنين يقوم اللّيل كما أمره الله و كانت طائفة من أصحابه يقومون معه فأنزل الله بعد عشر سنين( إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ - إلى قوله -وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ ) فخفّف الله عنهم بعد عشر سنين.
أقول: و روي نزول آية التخفيف بعد سنة و روي أيضاً نزولها بعد ثمانية أشهر، و لم يكن قيام الليل واجباً على غير النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم كما اُشير إليه بقوله تعالى:( إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ ) الآية كما تقدّم، و يؤيّده ما في الرواية من قوله:( و طائفة من أصحابه) .
و في التهذيب، بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفرعليهالسلام قال: سألته عن قول الله تعالى:( قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ) قال: أمره الله أن يصلّي كلّ ليلة إلّا أن تأتي عليه ليلة من اللّيالي لا يصلّي فيها شيئاً.
أقول: الرواية تشير إلى أحد الوجوه في الآية.
و في المجمع: و قيل: إنّ نصفه بدل من القليل فيكون بياناً للمستثنى، و يؤيّد هذا القول ما روي عن الصادقعليهالسلام قال: القليل النصف أو انقص من القليل قليلاً أو زد على القليل قليلاً.
و في الدرّ المنثور، أخرج العسكريّ في المواعظ عن عليّعليهالسلام أنّ رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم سئل عن قول الله:( وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ) قال: بيّنه تبييناً، و لا تنثره نثر الدقل، و لا تهذّه هذّ الشعر، قفوا عند عجائبه، و حرّكوا به القلوب، و لا يكن همّ أحدكم آخر السورة.
أقول: و روي هذا المعنى في اُصول الكافي، بإسناده عن عبدالله بن سليمان عن الصادق
____________________
(1) جئث الرجل ثقل عند القيام أو عند حمل شيء ثقيل و الفرق: الفزع و الخوف.
عن عليّعليهالسلام و لفظ بيّنه تبييناً و لا تهذّه هذّ الشعر، و لا تنثره نثر الرمل، و لكن أفرغوا(1) قلوبكم القاسية و لا يكن هم أحدكم آخر السورة.
و فيه، أخرج ابن أبي شيبة عن طاووس قال: سئل رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم أيّ الناس أحسن قراءة قال الّذي إذا سمعته يقرأ رأيت أنّه يخشى الله.
و في اُصول الكافي، بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة قال قال أبوعبداللهعليهالسلام : إنّ القرآن لا يقرأ هذرمة(2) و لكن يرتّل ترتيلاً فإذا مررت بآية فيها ذكر الجنّة فقف عندها و اسأل الله عزّوجلّ الجنّة، و إذا مررت بآية فيها ذكر النار فقف عندها و تعوّذ بالله من النار.
و في المجمع، في معنى الترتيل عن أبي بصير عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: هو أن تتمكّث فيه و تحسن به صوتك.
و فيه، روي عن اُمّ سلمة أنّها قالت: كان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم يقطع قراءته آية آية.
و فيه، عن أنس قال: كانصلىاللهعليهوآلهوسلم يمدّ صوته مدّاً.
و فيه، سأل الحارث بن هشام رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقالصلىاللهعليهوآلهوسلم : أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس و هو أشدّ علي فيفصم(3) عنّي و قد وعيت ما قال و أحياناً يتمثّل الملك رجلاً فأعي ما يقول.
قالت عائشة: إنّه كان ليوحي إلى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم و هو على راحلته فتضرب بجرانها.
قالت: و لقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه و إنّ جبينه ليرفضّ عرقاً.
و عن تفسير العيّاشيّ، بإسناده عن عيسى بن عبيد عن أبيه عن جدّه عن عليّعليهالسلام قال: كان القرآن ينسخ بعضه بعضاً، و إنّما يؤخذ من أمر رسول الله
____________________
(1) أفرغ الإناء: أخلاه.
(2) الهذرمة: الإسراع في القراءة.
(3) الفصم: القطع.
صلىاللهعليهوآلهوسلم بآخره.
و كان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة نسخت ما قبلها و لم ينسخها شيء لقد نزلت عليه و هو على بغلة شهباء و ثقل عليها الوحي حتّى وقفت و تدلّى بطنها حتّى رأيت سرّتها تكاد تمسّ الأرض.
أقول: إن صحّت الرواية كان ظهور أثر ثقل الوحي على الناقة أو البغلة من قبيل تجسّم المعاني و كثيراً ما يوجد مثله فيما نقل من المعجزات و كرامات الأولياء، و أمّا اتّصاف الوحي و هو كلام بالثقل المادّيّ فغير معقول.
و في التهذيب، بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبداللهعليهالسلام في قول الله عزّوجلّ:( إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِيلًا ) قال: يعني بقوله:( وَ أَقْوَمُ قِيلًا ) قيام الرجل عن فراشه يريد به الله عزّوجلّ لا يريد به غيره.
أقول: و رواه أيضاً بسندين آخرين في التهذيب و العلل عن هشام عنهعليهالسلام .
و في المجمع في قوله تعالى:( إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ ) الآية: و المرويّ عن أبي جعفر و أبي عبداللهعليهماالسلام أنّهما قالا: هي القيام في آخر اللّيل.
و في الدرّ المنثور، أخرج ابن المنذر عن حسين بن عليّ أنّه رؤي يصلّي بين المغرب و العشاء فقيل له في ذلك؟ فقال: إنّهما من الناشئة.
و في المجمع: في قوله تعالى:( وَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ) وروى محمّد بن مسلم و زرارة و حمران عن أبي جعفر و أبي عبداللهعليهماالسلام أنّ التبتّل هذا رفع اليدين في الصلاة. و في رواية أبي بصير قال: هو رفع يدك إلى الله و تضرّعك.
أقول: و ينطبق على قنوت الصلاة، و في رواية هو رفع اليدين و تحريك السبّابتين، و في رواية الإيماء بالإصبع و في رواية الدعاء بإصبع واحدة يشير بها.
و فيه في قوله تعالى:( وَ طَعاماً ذا غُصَّةٍ ) الآية: عن عبدالله بن عمر: أنّ النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم سمع قارئاً يقرأ هذا فصعق.
و في تفسير القمّيّ في قوله:( وَ كانَتِ الْجِبالُ كَثِيباً مَهِيلًا ) قال: مثل الرمل ينحدر.
( سورة المزّمّل آية 20)
إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( 20 )
( بيان)
آية مبنيّة على التخفيف فيما أمر به النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم في صدر السورة من قيام الليل و الصلاة فيه ثمّ عمّم الحكم لسائر المؤمنين بقوله:( إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ ) الآية.
و لسان الآية هو التخفيف بما تيسّر من القرآن من غير نسخ لأصل الحكم السابق بالمنع عن قيام ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه.
و قد ورد في غير واحد من الأخبار أنّ الآية مكّيّة نزلت بعد ثمانية أشهر أو سنة أو عشر سنين من نزول آيات صدر السورة لكن يوهنه اشتمال الآية على قوله تعالى:( وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ أَقْرِضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً ) فإنّ ظاهره أنّ المراد
بالزكاة - و قد ذكرت قبلها الصلاة و بعدها الإنفاق المستحبّ - هو الزكاة المفروضة و إنّما فرضت الزكاة بالمدينة بعد الهجرة.
و قول بعضهم: إنّ الزكاة فرضت بمكّة من غير تعيين الأنصباء و الّذي فرض بالمدينة تعيين الأنصباء، تحكّم من غير دليل، و كذا قول بعضهم: إنّه من الممكن أن تكون الآية ممّا تأخّر حكمه عن نزوله.
على أنّ في الآية ذكراً من القتال إذ يقول:( وَ آخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ) و لم يكن من مصلحة الدعوة الحقّة يومئذ ذاك و الظرف ذلك الظرف أن يقع في متنها ذكر من القتال بأيّ وجه كان، فالظاهر أنّ الآية مدنيّة و ليست بمكّيّة و قد مال إليه بعضهم.
قوله تعالى: ( إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ ) إلى آخر الآية. الخطاب للنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم و في التعبير بقوله:( رَبَّكَ ) تلويح إلى شمول الرحمة و العناية الإلهيّة، و كذا في قوله:( يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ) إلخ مضافاً إلى ما فيه من لائحة الشكر قال تعالى:( وَ كانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً ) الدهر: 22.
و قوله:( تَقُومُ أَدْنى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ ) أدنى اسم تفضيل من الدنوّ بمعنى القرب، و قد جرى العرف على استعمال أدنى فيما يقرب من الشيء و هو أقلّ فيقال: إنّ عدّتهم أدنى من عشرة إذا كانوا تسعة مثلاً دون ما لو كانوا أحد عشر فمعنى قوله:( أَدْنى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ ) أقرب من ثلثيه و أقلّ بقليل.
و الواو العاطفة في قوله:( وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ ) لمطلق الجمع و المراد أنّه يعلم أنّك تقوم في بعض الليالي أدنى من ثلثي الليل و في بعضها نصفه و في بعضها ثلثه.
و قوله:( وَ طائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ) المراد المعيّة في الإيمان و( مِنْ ) للتبعيض فالآية تدلّ على أنّ بعضهم كان يقوم الليل كما كان يقومه النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم . و قيل( من ) بيانيّة، و هو كما ترى.
و قوله:( وَ اللهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ ) في مقام التعليل لقوله:( إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ ) و المعنى و كيف لا يعلم و هو الله الّذي إليه الخلق و التقدير ففي تعيين قدر اللّيل و النهار
تعيين ثلثهما و نصفهما و ثلثيهما، و نسبة تقدير اللّيل و النهار إلى اسم الجلالة دون اسم الربّ و غيره لأنّ التقدير من شؤن الخلق و الخلق إلى الله الّذي إليه ينتهي كلّ شيء.
و قوله:( عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ) الإحصاء تحصيل مقدار الشيء و عدده و الإحاطة به، و ضمير( لَنْ تُحْصُوهُ ) للتقدير أو للقيام مقدار ثلث الليل أو نصفه أو أدنى من ثلثيه، و إحصاء ذلك مع اختلاف الليالي طولاً و قصراً في أيّام السنة ممّا لا يتيسّر لعامّة المكلّفين و يشتدّ عسراً لمن نام أوّل اللّيل و أراد القيام بأحد المقادير الثلاثة دون أن يحتاط بقيام جميع اللّيل أو ما في حكمه.
فالمراد بقوله:( عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ ) علمه تعالى بعدم تيسّر إحصاء المقدار الّذي اُمروا بقيامه من اللّيل لعامّة المكلّفين.
و المراد بقوله:( فَتابَ عَلَيْكُمْ ) توبته تعالى و رجوعه إليهم بمعنى انعطاف الرحمة الإلهيّة عليهم بالتخفيف فللّه سبحانه توبة على عباده ببسط رحمته عليهم و أثرها توفيقهم للتوبة أو لمطلق الطاعة أو رفع بعض التكاليف أو التخفيف قال تعالى:( ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ) التوبة: 118.
كما أنّ له توبة عليهم بمعنى الرجوع إليهم بعد توبتهم و أثرها مغفرة ذنوبهم، و قد تقدّمت الإشارة إليه.
و المراد بقوله:( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ) التخفيف في قيام اللّيل من حيث المقدار لعامّة المكلّفين تفريعاً على علمه تعالى أنّهم لن يُحصوه.
و لازم ذلك التوسعة في التكليف بقيام اللّيل من حيث المقدار حتّى يسع لعامّة المكلّفين الشاقّ عليهم إحصاؤه دون النسخ بمعنى كون قيام الثلث أو النصف أو الأدنى من الثلثين لمن استطاع ذلك بدعة محرّمة و ذلك أنّ الإحصاء المذكور إنّما لا يتيسّر لمجموع المكلّفين لا لجميعهم و لو امتنع لجميعهم و لم يتيسّر لأحدهم لم يشرّع من أصله و لا يكلّف الله نفساً إلّا وسعها.
على أنّه تعالى يصدّق لنبيّهصلىاللهعليهوآلهوسلم و طائفة من الّذين معه قيام الثلث و النصف
و الأدنى من الثلثين و ينسب عدم التمكّن من الإحصاء إلى الجميع و هم لا محالة هم القائمون و غيرهم فالحكم إنّما كان شاقّاً على المجموع من حيث المجموع دون كلّ واحد فوسّع في التكليف بقوله:( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ) و سهّل الأمر بالتخفيف ليكون لعامّة المكلّفين فيه نصيب مع بقاء الأصل المشتمل عليه صدر السورة على حاله لمن تمكّن من الإحصاء و إرادة، و الحكم استحبابيّ لسائر المؤمنين و إن كان ظاهر ما للنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم من الخطاب الوجوب كما تقدّمت الإشارة إليه.
و للقوم في كون المراد بقيام اللّيل الصلاة فيه أو قراءة القرآن خارج الصلاة، و على الأوّل في كونه واجباً على النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم و المؤمنين أو مستحبّاً للجميع أو واجباً على النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم مستحبّاً لغيره ثمّ في نسخ الحكم بالتخفيف بما تيسّر بهذه الآية أو تبديل الصلاة من قراءة ما تيسّر من القرآن أقوال لا كثير جدوى في التعرّض لها و البحث عنها.
و قوله:( عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى وَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَ آخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ) إشارة إلى مصلحة اُخرى مقتضية للتخفيف في أمر القيام ثلث اللّيل أو نصفه أو أدنى من ثلثيه، وراء كونه شاقّاً على عامّة المكلّفين بالصفة المذكورة أوّلاً فإنّ الإحصاء المذكور للمريض و المسافر و المقاتل مع ما هم عليه من الحال شاقّ عسير جدّاً.
و المراد بالضرب في الأرض للابتغاء من فضل الله طلب الرزق بالمسافرة من أرض إلى أرض للتجارة.
و قوله:( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ أَقْرِضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً ) تكرار للتخفيف تأكيداً، و ضمير( مِنْهُ ) للقرآن، و المراد الإتيان بالصلاة على ما يناسب سعة الوقت الّذي قاموا فيه.
و المراد بالصلاة المأمور بإقامتها الفريضة فإن كانت الآية مدنيّة فالفرائض الخمس اليوميّة و إن كانت مكّيّة فبحسب ما كانت مفروضة من الصلاة، و المراد بالزكاة الزكاة المفروضة، و المراد بإقراضه تعالى غير الزكاة من الإنفاقات الماليّة في سبيل الله.
و عطف الأمر بإقامة الصلاة و إيتاء الزكاة و الإقراض للتلويح إلى أنّ التكاليف الدينيّة على حالها في وجوب الاهتمام بها و الاعتناء بأمرها، فلا يتوهّمنّ متوهّم سريان التخفيف و المسامحة في جميع التكاليف فالآية نظيرة قوله في آية النجوى:( فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ أَطِيعُوا اللهَ وَ رَسُولَهُ ) المجادلة: 13.
و قوله:( وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْراً وَ أَعْظَمَ أَجْراً ) ( مِنْ خَيْرٍ ) بيان للموصول، و المراد بالخير مطلق الطاعة أعمّ من الواجبة و المندوبة، و( هُوَ ) ضمير فصل أو تأكيد للضمير في( تَجِدُوهُ ) .
و المعنى: و الطاعة الّتي تقدّمونها لأنفسكم - أي لتعيشوا بها في الآخرة - تجدونها عند الله - أي في يوم اللقاء - خيراً من كلّ ما تعملون أو تتركون و أعظم أجرا.
و قوله:( وَ اسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ختم الكلام بالأمر بالاستغفار، و في قوله:( إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) إشعار بوعد المغفرة و الرحمة، و لا يبعد أن يكون المراد بالاستغفار الإتيان بمطلق الطاعات لأنّها وسائل يتوسّل بها إلى مغفرة الله فالإتيان بها استغفار.
( بحث روائي)
في تفسير القمّيّ، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرعليهالسلام في قوله تعالى:( إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ ) ففعل النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم ذلك و بشّر الناس به فاشتدّ ذلك عليهم و( عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ ) و كان الرجل يقوم و لا يدري متى ينتصف اللّيل و متى يكون الثلثان، و كان الرجل يقوم حتّى يصبح مخافة أن لا يحفظه.
فأنزل الله( إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ - إلى قوله -عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ ) يقول: متى يكون النصف و الثلث نسخت هذه الآية( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ) ، و
اعلموا أنّه لم يأت نبيّ قطّ إلّا خلا بصلاة اللّيل، و لا جاء نبيّ قطّ بصلاة اللّيل في أوّل اللّيل.
أقول: محصّل الرواية أنّ صدر السورة توجب صلاة اللّيل و ذيلها تنسخها، و روي ما يقرب منه من طرق أهل السنّة عن ابن عبّاس و غيره، و قد تقدّم ما يتعلّق به في البيان السابق.
و في المجمع، روى الحاكم أبوالقاسم إبراهيم الحسكانيّ بإسناده عن الكلبيّ عن أبي صالح عن ابن عبّاس في قوله تعالى:( وَ طائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ) قال: عليّ و أبوذرّ.
و فيه في قوله تعالى:( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ ) روي عن الرضا عن أبيه عن جدّهعليهمالسلام قال: ما تيسّر منه لكم فيه خشوع القلب و صفاء السرّ.
و في الدرّ المنثور، أخرج ابن أبي حاتم و الطبرانيّ و ابن مردويه عن ابن عبّاس عن النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ ) قال: مائة آية.
و فيه، أخرج ابن مردويه عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : ما من جالب يجلب طعاماً إلى بلد من بلاد المسلمين فيبيعه بسعر يومه إلّا كانت منزلته عند الله منزلة الشهيد. ثمّ قرأ رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ( وَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَ آخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ) .
و في تفسير القمّيّ، بإسناده عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن قول الله:( وَ أَقْرِضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً ) قال: هو غير الزكاة.
و في الخصال، عن أميرالمؤمنينعليهالسلام في حديث الأربعمائة: أكثروا الاستغفار تجلبوا الرزق، و قدّموا ما استطعتم من عمل الخير تجدوه غداً.
أقول: ذيله مأخوذ من قوله تعالى:( وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْراً وَ أَعْظَمَ أَجْراً ) .
( سورة المدّثّر مكّيّة و هي ستّ و خمسون آية)
( سورة المدّثّر الآيات 1 - 7)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ( 1 ) قُمْ فَأَنذِرْ ( 2 ) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ( 3 ) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ( 4 ) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ( 5 ) وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ( 6 ) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ( 7 )
( بيان)
تتضمّن السورة أمر النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم بالإنذار في سياق يلوح منه كونه من أوامر أوائل البعثة ثمّ الإشارة إلى عظم شأن القرآن الكريم و جلالة قدره، و الوعيد الشديد على من يواجهه بالإنكار و الرمي بالسحر، و ذمّ المعرضين عن دعوته.
و السورة مكّيّة من العتائق النازلة في أوائل البعثة و ظهور الدعوة حتّى قيل: إنّها أوّل سورة نزلت من القرآن و إن كان يكذّبه نفس آيات السورة الصريحة في سبق قراءتهصلىاللهعليهوآلهوسلم القرآن على القوم و تكذيبهم به و إعراضهم عنهم و رميهم له بأنّه سحر يؤثر.
و لذا مال بعضهم إلى أنّ النازل أوّلاً هي الآيات السبع الواقعة في أوّل السورة و لازمه كون السورة غير نازلة دفعة و هو و إن كان غير بعيد بالنظر إلى متن الآيات السبع لكن يدفعه سياق أوّل سورة العلق الظاهر في كونه أوّل ما نزل من القرآن.
و احتمل بعضهم أن تكون السورة أوّل ما نزل على النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم عند الأمر بإعلان الدعوة بعد إخفائها مدّة في أوّل البعثة فهي في معنى قوله:( فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ) الحجر: 94، و بذلك جمع بين ما ورد من أنّها أوّل ما نزل، و ما ورد أنّها نزلت بعد سورة العلق، و ما ورد أنّ سورتي المزّمّل و المدّثّر نزلتا معاً، و هذا القول لا يتعدّى طور الاحتمال.
و كيف كان فالمتيقّن أنّ السورة من أوائل ما نزل على النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم من السور القرآنيّة، و الآيات السبع الّتي نقلناها تتضمّن الأمر بالإنذار و سائر الخصال الّتي تلزمه ممّا وصّاه الله به.
قوله تعالى: ( يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ) المدّثّر بتشديد الدالّ و الثاء أصله المتدثّر اسم فاعل من التدثّر بمعنى التغطّي بالثياب عند النوم.
و المعنى: يا أيّها المتغطّي بالثياب للنوم خطاب للنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم و قد كان على هذه الحال فخوطب بوصف مأخوذ من حاله تأنيساً و ملاطفة نظير قوله:( يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ) .
و قيل: المراد بالتدثّر تلبّسهصلىاللهعليهوآلهوسلم بالنبوّة بتشبيهها بلباس يتحلّى به و يتزيّن و قيل: المراد به اعتزالهصلىاللهعليهوآلهوسلم و غيبته عن النظر فهو خطاب له بما كان عليه في غار حراء، و قيل: المراد به الاستراحة و الفراغ فكأنّه قيل لهصلىاللهعليهوآلهوسلم : يا أيّها المستريح الفارغ قد انقضى زمن الراحة و أقبل زمن متاعب التكاليف و هداية الناس.
و هذه الوجوه و إن كانت في نفسها لا بأس بها لكنّ الّذي يسبق إلى الذهن هو المعنى الأوّل.
قوله تعالى: ( قُمْ فَأَنْذِرْ ) الظاهر أنّ المراد به الأمر بالإنذار من غير نظر إلى من ينذر فالمعنى افعل الإنذار، و ذكر بعضهم أنّ مفعول الفعل محذوف، و التقدير أنذر عشيرتك الأقربين لمناسبته لابتداء الدعوة كما ورد في سورة الشعراء.
و ذكر آخرون أنّ المفعول المحذوف عامّ و هو جميع الناس لقوله:( وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ ) سبأ: 28.
و لم يذكر التبشير مع الإنذار مع أنّهما كالمتلازمين في تمام الدعوة لأنّ السورة ممّا نزل في ابتداء الدعوة و الإنذار هو الغالب إذ ذاك.
قوله تعالى: ( وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ ) أي أنسب ربّك إلى الكبرياء و العظمة اعتقاداً و عملاً قولاً و فعلاً و هو تنزيهه تعالى من أن يعادله أو يفوقه شيء فلا شيء يشاركه أو يغلبه أو يمانعه، و لا نقص يعرضه، و لا وصف يحده.
و لذا ورد عن أئمّة أهل البيتعليهمالسلام أنّ معنى التكبير: الله أكبر من أن يوصف، فهو تعالى أكبر من كلّ وصف نصفه به حتّى من هذا الوصف، و هذا هو المناسب للتوحيد الإسلاميّ الّذي يفوق ما نجده من معنى التوحيد في سائر الشرائع السماوية.
و هذا الّذي ذكرناه هو الفرق بين كلمتي التكبير و التسبيح - الله أكبر و سبحان الله - فسبحان الله تنزيه له تعالى عن كلّ وصف عدميّ مبنيّ على النقص كالموت و العجز و الجهل و غير ذلك، و الله أكبر تنزيه مطلق له تعالى عن كلّ وصف نصفه به أعمّ من أن يكون عدميّاً أو وجوديّاً حتّى من نفس هذا الوصف لما أنّ كلّ مفهوم محدود في نفسه لا يتعدّى إلى غيره من المفاهيم و هو تعالى لا يحيط به حدّ، فافهم ذلك.
و قيل: المراد الأمر بالتكبير في الصلاة.
و التعبير عنه تعالى بربّك لا يخلو من إشعار بأنّ توحيده تعالى يومئذ كان يختصّ بهصلىاللهعليهوآلهوسلم .
قال في الكشّاف، في قوله:( فَكَبِّرْ ) و دخلت الفاء لمعنى الشرط كأنّه قيل: و ما كان فلا تدع تكبيره.
قوله تعالى: ( وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) قيل: كناية عن إصلاح العمل، و لا يخلو من وجه فإنّ العمل بمنزلة الثياب للنفس بما لها من الاعتقاد فالظاهر عنوان الباطن، و كثيراً ما يكنّى في كلامهم عن صلاح العمل بطهارة الثياب.
و قيل: كناية عن تزكية النفس و تنزيهها عن الذنوب و المعاصي.
و قيل: المراد تقصير الثياب لأنّه أبعد من النجاسة و لو طالت و انجرّت على الأرض لم يؤمن أن تتنجّس.
و قيل: المراد تطهير الأزواج من الكفر و المعاصي لقوله تعالى:( هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ ) البقرة: 187.
و قيل: الكلام على ظاهره و المراد تطهير الثياب من النجاسات للصلاة و الأقرب على هذا أن يجعل قوله:( وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ ) إشارة إلى تكبير الصلاة و تكون الآيتان مسوقتين لتشريع أصل الصلاة مقارناً للأمر بالدعوة.
و لا يرد عليه ما قيل: إنّ نزول هذه الآيات كان حيث لا صلاة أصلاً و ذلك أنّ تشريع الفرائض الخمس اليوميّة على ما هي عليها اليوم و إن كان في ليلة المعراج و هي جميعاً عشر ركعات ثمّ زيد عليها سبع ركعات إلّا أنّ أصل الصلاة كان منذ أوائل البعثة كما يشهد به ذكرها في هذه السورة و سورتي العلق و المزّمّل، و يدلّ عليه الروايات.
و قيل: المراد بتطهير الثياب التخلّق بالأخلاق الحميدة و الملكات الفاضلة.
و في معنى تطهير الثياب أقوال اُخر أغمضنا عن نقلها لإمكان إرجاعها إلى بعض ما تقدّم من الوجوه، و أرجح الوجوه المتقدّمة أوّلها و خامسها.
قوله تعالى: ( وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ ) قيل: الرجز بضمّ الراء و كسرها العذاب، و المراد بهجره هجر سببه و هو الإثم و المعصية، و المعنى اهجر الإثم و المعصية.
و قيل: الرجز اسم لكلّ قبيح مستقذر من الأفعال و الأخلاق فالأمر بهجره أمر بترك كلّ ما يكرهه الله و لا يرتضيه مطلقاً، أو أمر بترك خصوص الأخلاق الرذيلة الذميمة على تقدير أن يكون المراد بتطهير الثياب ترك الذنوب و المعاصي.
و قيل: الرجز هو الصنم فهو أمر بترك عبادة الأصنام.
قوله تعالى: ( وَ لا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ) الّذي يعطيه سياق الآيات و يناسب المقام أن يكون المراد بالمنّ تكدير الصنيعة بذكرها للمنعم عليه كما في قوله تعالى:( لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى ) البقرة: 264، و قوله:( يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ) الحجرات: 17 و المراد بالاستكثار رؤية الشيء و حسبانه كثيراً لا طلب الكثرة.
و المعنى: لا تمنن امتثالك لهذه الأوامر و قيامك بالإنذار و تكبيرك ربّك و تطهيرك ثيابك و هجرك الرجز حال كونك ترى ذلك كثيرا و تعجبه - فإنّما أنت عبد لا تملك من نفسك شيئاً إلّا ما ملّكك الله و أقدرك عليه و هو المالك لما ملّكك و القادر على ما عليه أقدرك فله الأمر و عليك الامتثال -.
و للقوم في الآية وجوه اُخر من التفسير لا تلائم السياق تلك الملاءمة فقيل المعنى لا تعط عطيّة لتعطى أكثر منها.
و قيل: المعنى لا تمنن ما أعطاك الله من النبوّة و القرآن على الناس مستكثراً به الأجر.
و قيل: أي لا تمنن إبلاغ الرسالة على اُمتك.
و قيل: المعنى لا تضعف في عملك مستكثراً لطاعاتك.
و قيل: المعنى لا تمنن بعطائك على الناس مستكثراً له.
و قيل: أي إذا أعطيت عطيّة فأعطها لربّك و اصبر حتّى يكون هو الّذي يثيبك.
و قيل: هو نهي عن الربا المحرّم أي لا تعط شيئاً طالباً أن تعطي أكثر ممّا أعطيت.
قوله تعالى: ( وَ لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ) أي لوجه ربّك، و الصبر مطلق يشمل الصبر عند المصيبة و الصبر على الطاعة و الصبر عن المعصية، و المعنى و لوجه ربّك فاصبر عند ما يصيبك من المصيبة و الأذى في قيامك بالإنذار و امتثالك هذه الأوامر و اصبر على طاعة الله و اصبر عن معصيته، و هذا معنى جامع لمتفرّقات ما ذكروه في تفسير الآية كقول بعضهم: إنّه أمر بنفس الفعل من غير نظر إلى متعلّقه، و قول بعضهم: إنّه الصبر على أذى المشركين، و قول بعضهم: إنّه الصبر على أداء الفرائض، إلى غير ذلك.
( بحث روائي)
في الدرّ المنثور، أخرج الطيالسي و عبدالرزّاق و أحمد و عبد بن حميد و البخاريّ و مسلم و الترمذيّ و ابن الضريس و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه و ابن الأنباريّ في المصاحف عن يحيى بن أبي كثير قال: سألت أباسلمة بن عبدالرحمن عن أوّل ما نزل من القرآن فقال: يا أيّها المدّثّر قلت: يقولون:( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ) ؟ فقال أبوسلمة: سألت جابر بن عبدالله عن ذلك، قلت له مثل ما قلت. قال جابر: لا اُحدّثك إلّا ما حدّثنا رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم .
قال: جاورت بحراء فلمّا قضيت جواري نوديت فنظرت عن يميني فلم أر شيئاً و نظرت عن شمالي فلم أر شيئاً، و نظرت خلفي فلم أر شيئاً فرفعت رأسي فإذا الملك الّذي جاءني بحراء جالس على كرسيّ بين السماء و الأرض فجثت منه رعبا فرجعت فقلت: دثّروني دثّروني فنزلت:( يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ - إلى قوله -وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ ) .
أقول: الحديث معارض بالأحاديث الآخر الدالّة على كون سورة اقرأ أوّل ما نزل من القرآن و يؤيّدها سياق سورة اقرأ، على أنّ قوله:( فإذا الملك الّذي جاءني بحراء) يشعر بنزول الوحي عليه قبلاً.
و فيه، أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة: قلنا: يا رسول الله كيف نقول إذا دخلنا في الصلاة؟ فأنزل الله( وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ ) فأمرنا رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم أن نفتتح الصلاة بالتكبير.
أقول: و في الرواية شيء فأبو هريرة ممّن آمن بعد الهجرة بكثير و السورة ممّا نزل في أوّل البعثة فأين كان أبوهريرة أو الصحابة يومئذ؟.
و في الخصال، عن أميرالمؤمنينعليهالسلام في حديث الأربعمائة: تشمير الثياب طهور لها قال الله تبارك و تعالى:( وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) يعني فشمّر.
أقول: و في المعنى عدّة أخبار مرويّة في الكافي، و المجمع، عن أبي جعفر و أبي عبدالله و أبي الحسنعليهمالسلام .
و في الدرّ المنثور، أخرج الحاكم و صحّحه و ابن مردويه عن جابر قال: سمعت رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم يقول:( وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ ) برفع الراء، و قال: هي الأوثان.
أقول: و قوله:( هي الأوثان) من كلام جابر أو غيره من رجال السند.
و في تفسير القمّيّ في قوله تعالى:( وَ لا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ) و في رواية أبي الجارود يقول: لا تعط تلتمس أكثر منها.
( سورة المدّثّر الآيات 8 - 31)
فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ( 8 ) فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ( 9 ) عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ( 10 ) ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ( 11 ) وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا ( 12 ) وَبَنِينَ شُهُودًا ( 13 ) وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ( 14 ) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ( 15 ) كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ( 16 ) سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ( 17 ) إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ( 18 ) فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ( 19 ) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ( 20 ) ثُمَّ نَظَرَ ( 21 ) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ( 22 ) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ( 23 ) فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ( 24 ) إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ( 25 ) سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ( 26 ) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ( 27 ) لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ( 28 ) لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ( 29 ) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ( 30 ) وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ( 31 )
( بيان)
في الآيات وعيد شديد للطاعنين في القرآن الرامين له بأنّه سحر و المستهزئين لبعض ما فيه من الحقائق.
قوله تعالى: ( فَإِذا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ) النقر القرع و الناقور ما ينقر فيه للتصويت، و النقر في الناقور كالنفخ في الصور كناية عن بعث الموتى و إحضارهم لفصل القضاء يوم القيامة و الجملة شرطيّة جزاؤها قوله:( فذلك ) إلخ.
قوله تعالى: ( فَذلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ) الإشارة بقوله:( فَذلِكَ ) إلى زمان نقر الناقور و لا يبعد أن يكون المراد بيومئذ يوم إذ يرجعون إلى الله للحساب و الجزاء أو يوم إذ يرجع الخلائق إلى الله فيكون ظرفاً ليوم نقر الناقور فمن الجائز أن تعتبر قطعة من الزمان ظرفاً لبعض أجزائه كالسنة تجعل ظرفاً للشهر و الشهر يجعل ظرفاً لليوم لنوع من العناية أو يعتبر زمان متعدّداً مختلفاً باختلاف صفاته أو الحوادث الواقعة فيه ثمّ يجعل باعتبار بعض صفاته ظرفاً لنفسه باعتبار صفة اُخرى.
و المعنى فزمان نقر الناقور الواقع في يوم رجوع الخلائق إلى الله زمان عسير على الكافرين أو زمان نقر الناقور زمان عسير على الكافرين في يوم الرجوع - بناء على كون قوله:( يَوْمَئِذٍ ) قيداً لقوله:( فَذلِكَ ) أو لقوله:( يَوْمٌ ) -.
و قال في الكشّاف: فإن قلت: بم انتصب إذا و كيف صحّ أن يقع يومئذ ظرفاً ليوم عسير؟ قلت: انتصب إذا بما دلّ عليه الجزاء لأنّ المعنى إذا نقر في الناقور عسر الأمر على الكافرين، و الّذي أجاز وقوع يومئذ ظرفاً ليوم عسير أنّ المعنى فذلك وقت النقر وقوع يوم عسير لأنّ يوم القيامة يأتي و يقع حين ينقر في الناقور. انتهى.
و قال: و يجوز أن يكون يومئذ مبنيّاً مرفوع المحلّ بدلاً من ذلك، و يوم عسير خبر كأنّه قيل: فيوم النقر يوم عسير. انتهى.
و قوله:( غَيْرُ يَسِيرٍ ) وصف آخر ليوم مؤكّد لعسره و يفيد أنّه عسير من كلّ وجه من وجه دون وجه.
قوله تعالى: ( ذَرْنِي وَ مَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً ) كلمة تهديد و قد استفاض النقل أنّ الآية و ما يتلوها إلى تمام عشرين آية نزلت في الوليد بن المغيرة، و ستأتي قصّته في البحث الروائيّ الآتي إن شاء الله تعالى.
و قوله:( وَحِيداً ) حال من فاعل( خَلَقْتُ ) و محصّل المعنى: دعني و من خلقته حال كوني وحيداً لا يشاركني في خلقه أحد ثمّ دبّرت أمره أحسن التدبير، و لا تحل بيني و بينه فأنا أكفيه.
و من المحتمل أن يكون حالاً من مفعول( ذَرْنِي ) . و قيل: حال من مفعول خلقت المحذوف و هو ضمير عائد إلى الموصول، و محصّل المعنى دعني و من خلقته حال كونه وحيداً لا مال له و لا بنون، و احتمل أيضاً أن يكون( وَحِيداً ) منصوباً بتقدير( أذم) و أحسن الوجوه أوّلها.
قوله تعالى: ( وَ جَعَلْتُ لَهُ مالًا مَمْدُوداً ) أي مبسوطاً كثيراً أو ممدوداً بمدد النماء.
قوله تعالى: ( وَ بَنِينَ شُهُوداً ) أي حضوراً يشاهدهم و يتأيّد بهم، و هو عطف على قوله:( مالًا ) .
قوله تعالى: ( وَ مَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيداً ) التمهيد التهيئة و يتجوّز به عن بسطة المال و الجاه و انتظام الاُمور.
قوله تعالى: ( ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كانَ لِآياتِنا عَنِيداً ) أي ثمّ يطمع أن أزيد فيما جعلت له من المال و البنين و مهّدت له من التمهيد.
و قوله:( كَلَّا ) ردع له، و قوله:( إِنَّهُ كانَ ) إلخ تعليل المردع، و العنيد المعاند المباهي بما عنده، قيل، ما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في نقصان من ماله و ولده حتّى هلك.
قوله تعالى: ( سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً ) الإرهاق الغشيان بالعنف، و الصعود عقبة الجبل الّتي يشقّ مصعدها شبّه ما سيناله من سوء الجزاء و مرّ العذاب بغشيانه عقبة وعر صعبة الصعود.
قوله تعالى: ( إِنَّهُ فَكَّرَ وَ قَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ) التفكير معروف، و التقدير عن تفكير نظم معان و أوصاف في الذهن بالتقديم و التأخير و الوضع و الرفع لاستنتاج غرض مطلوب، و قد كان الرجل يهوى أن يقول في أمر القرآن شيئاً يبطل به
دعوته و يرضي به قومه المعاندين ففكّر فيه أ يقول: شعر أو كهانة أو هذرة جنون أو أسطورة فقدّر أن يقول: سحر من كلام البشر لأنّه يفرّق بين المرء و أهله و ولده و مواليه.
و قوله:( فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ) دعا عليه على ما يعطيه السياق نظير قوله:( قاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ) التوبة: 30.
و قوله:( ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ) تكرار للدعاء تأكيداً.
قوله تعالى: ( ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَ اسْتَكْبَرَ فَقالَ إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هذا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ) تمثيل لحاله بعد التكفير و التقدير و هو من ألطف التمثيل و أبلغه.
فقوله:( ثُمَّ نَظَرَ ) أي ثمّ نظر بعد التفكير و التقدير نظرة من يريد أن يقضي في أمر سئل أن ينظر فيه - على ما يعطيه سياق التمثيل -.
و قوله:( ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَ ) العبوس تقطيب الوجه، قال في المجمع: و عبس يعبس عبوساً إذا قبض وجهه و العبوس و التكليح و التقطيب نظائر و ضدّها الطلاقة و البشاشة، و قال: و البسور بدء التكرّه في الوجه انتهى، فالمعنى ثمّ قبض وجهه و أبداً التكرّه في وجهه بعد ما نظر.
و قوله:( ثُمَّ أَدْبَرَ وَ اسْتَكْبَرَ ) الإدبار عن شيء الإعراض عنه، و الاستكبار الامتناع كبراً و عتوّاً، و الأمران أعني الإدبار و الاستكبار من الأحوال الروحيّة، و إنّما رتّبا في التمثيل على النظر و العبوس و البسور و هي أحوال صوريّة محسوسة لظهورهما
بقوله:( إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ ) إلخ، و لذا عطف قوله:( فَقالَ إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ) بالفاء دون( ثُمَّ ) .
و قوله:( فَقالَ إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ) أي أظهر إدباره و استكباره بقوله مفرّعاً عليه:( إِنْ هذا - أي القرآن -إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ) أي يروي و يتعلّم من السحرة.
و قوله:( إِنْ هذا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ) أي ليس بكلام الله كما يدّعيه محمّدصلىاللهعليهوآلهوسلم .
قيل: إنّ هذه الآية كالتأكيد للآية السابقة و إن اختلفتا معنى لأنّ المقصود منهما نفي كونه قرآناً من كلام الله، و باعتبار الاتّحاد في المقصود لم تعطف الجملة على الجملة.
قوله تعالى: ( سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَ ما أَدْراكَ ما سَقَرُ لا تُبْقِي وَ لا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ ) أي ساُدخله سقر و سقر من أسماء جهنّم في القرآن أو دركة من دركاتها، و جملة( سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ) بيان أو بدل من قوله:( سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً ) .
و قوله:( وَ ما أَدْراكَ ما سَقَرُ ) تفخيم لأمرها و تهويل.
و قوله:( لا تُبْقِي وَ لا تَذَرُ ) قضيّة إطلاق النفي أن يكون المراد أنّها لا تبقي شيئاً ممّن نالته إلّا أحرقته، و لا تدع أحداً ممّن اُلقي فيها إلّا نالته بخلاف نار الدنيا الّتي ربّما تركت بعض ما اُلقي فيها و لم تحرقه، و إذا نالت إنساناً مثلاً نالت جسمه و صفاته الجسميّة و لم تنل شيئاً من روحه و صفاته الروحيّة، و أمّا سقر فلا تدع أحداً ممّن اُلقي فيها إلّا نالته قال تعالى:( تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَ تَوَلَّى ) المعارج: 17، و إذا نالته لم تبق منه شيئاً من روح أو جسم إلّا أحرقته قال تعالى:( نارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ) الهمزة: 7.
و يمكن أن يراد أنّها لا تبقيهم أحياء و لا تتركهم يموتون فيكون في معنى قوله تعالى:( الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرى ثُمَّ لا يَمُوتُ فِيها وَ لا يَحْيى ) الأعلى: 13.
و قيل: المعنى لا تبقي شيئاً يلقى فيها إلّا أهلكته، و إذا هلك لم تذره هالكاً
حتّى يعاد فيعذّب ثانياً.
و قيل: المراد أنّها لا تبقي لهم لحماً و لا تذر عظماً، و قيل غير ذلك.
قوله تعالى: ( لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ ) اللوّاحة من التلويح بمعنى تغيير اللون إلى السواد و قيل: إلى الحمرة، و البشر جمع بشرة بمعنى ظاهر الجلد.
قوله تعالى: ( عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ ) يتولّون أمر عذاب المجرمين و قد اُبهم و لم يصرّح أنّهم من الملائكة أو غيرهم غير أنّ المستفاد من آيات القيامة - و تصرّح به الآية التالية - أنّهم من الملائكة.
و قد استظهر بعضهم أنّ مميّز قوله:( تِسْعَةَ عَشَرَ ) ملكاً ثمّ قال: أ لا ترى العرب و هم الفصحاء كيف فهموا منه ذلك فقد روي عن ابن عبّاس: أنّها لمّا نزلت( عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ ) قال أبوجهل لقريش: ثكلتكم اُمّهاتكم أ سمع ابن أبي كبشة يخبركم أنّ خزنة النار تسعة عشر و أنتم الدهم أ يعجز كلّ عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم؟ فقال أبو الأسد بن أسيد بن كلدة الجمحيّ و كان شديد البطش: أنا أكفيكم سبعة عشر فاكفوني أنتم اثنين انتهى، و أنت ترى أن لا دليل في كلامه على ما يدّعيه. على أنّه سمّي الواحد من الخزنة رجلاً و لا يطلق الرجل على الملك البتّة و لا سيمّا عند المشركين الّذين قال تعالى فيهم:( وَ جَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً ) الزخرف: 19.
قوله تعالى: ( وَ ما جَعَلْنا أَصْحابَ النَّارِ إِلَّا مَلائِكَةً ) إلى آخر الآية. سياق الآية يشهد على أنّهم تكلّموا فيما ذكر في الآية من عدد خزّان النار فنزلت هذه الآية، و يتأيّد بذلك ما ورد من سبب النزول و سيوافيك في البحث الروائيّ التالي.
فقوله:( وَ ما جَعَلْنا أَصْحابَ النَّارِ إِلَّا مَلائِكَةً ) المراد بأصحاب النار خزنتها الموكّلون عليها المتولّون لتعذيب المجرمين فيها كما يفيده قوله:( عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ ) و يشهد بذلك قوله بعد:( وَ ما جَعَلْنا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً ) إلخ.
و محصّل المعنى: أنّا جعلناهم ملائكة يقدرون على ما اُمروا به كما قال:
( عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعْصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ ) التحريم: 6.
فليسوا من البشر حتّى يرجوا المجرمون أن يقاوموهم و يطيقوهم.
و قوله:( وَ ما جَعَلْنا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ) الفتنة المحنة و الاختبار. ذكروا أنّ المراد بالجعل الجعل بحسب الإخبار دون الجعل بحسب التكوين فالمعنى و ما أخبرنا عن عدّتهم أنّها تسعة عشر إلّا ليكون فتنة للّذين كفروا، و يؤيّده ذيل الكلام:( لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ) إلخ.
و قوله:( لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ) الاستيقان وجدان اليقين في النفس أي ليوقن أهل الكتاب بأنّ القرآن النازل عليك حقّ حيث يجدون ما أخبرنا به من عدّة أصحاب النار موافقاً لما ذكر فيما عندهم من الكتاب.
و قوله:( وَ يَزْدادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيماناً ) أي بسبب ما يجدون من تصديق أهل الكتاب ذلك.
و قوله:( وَ لِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْكافِرُونَ ما ذا أَرادَ اللهُ بِهذا مَثَلًا ) اللّام في( لِيَقُولَ ) للعاقبة بخلاف اللّام في( لِيَسْتَيْقِنَ ) فللتعليل بالغاية، و الفرق أنّ قولهم:( ما ذا أَرادَ اللهُ بِهذا مَثَلًا ) تحقير و تهكّم و هو كفر لا يعدّ غاية لفعله سبحانه إلّا بالعرض بخلاف الاستيقان الّذي هو من الإيمان، و لعلّ اختلاف المعنيين هو الموجب لإعادة اللّام في قوله:( وَ لِيَقُولَ ) .
و قد فسّروا( الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ) بالشّكّ و الجحود بالمنافقين و فسّروا الكافرين بالمتظاهرين بالكفر من المشركين و غيرهم.
و قولهم:( ما ذا أَرادَ اللهُ بِهذا مَثَلًا ) أرادوا به التحقير و التهكّم يشيرون بهذا إلى قوله تعالى:( عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ ) و المثل الوصف، و المعنى ما الّذي يعنيه من وصف الخزنة بأنّهم تسعة عشر؟ فهذه العدّة القليلة كيف تقوى على تعذيب أكثر الثقلين من الجنّ و الإنس؟
( ذنابة لما تقدّم من الكلام في النفاق)
ذكر بعضهم أنّ قوله تعالى:( وَ لِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ) الآية - بناء على أنّ السورة بتمامها مكّيّة، و أنّ النفاق إنّما حدث بالمدينة - إخبار عمّا سيحدث من المغيّبات بعد الهجرة انتهى.
أمّا كون السورة بتمامها مكّيّة فهو المتعيّن من طريق النقل و قد ادّعي عليه إجماع المفسّرين، و ما نقل عن مقاتل أنّ قوله:( وَ ما جَعَلْنا أَصْحابَ النَّارِ إِلَّا مَلائِكَةً ) الآية مدنيّ لم يثبت من طريق النقل، و على فرض الثبوت هو قول نظري مبنيّ على حدوث النفاق بالمدينة و الآية تخبر عنه.
و أمّا حديث حدوث النفاق بالمدينة فقد أصرّ عليه بعضهم محتجّاً عليه بأنّ النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم و المسلمين لم يكونوا قبل الهجرة من القوّة و نفوذ الأمر و سعة الطول بحيث يهابهم الناس أو يرجى منهم خير حتّى يتّقوهم و يظهروا لهم الإيمان و يلحقوا بجمعهم مع إبطان الكفر و هذا بخلاف حالهم بالمدينة بعد الهجرة.
و الحجّة غير تامّة - كما أشرنا إليه في تفسير سورة المنافقون في كلام حول النفاق - فإنّ علل النفاق ليست تنحصر في المخافة و الاتّقاء أو الاستدرار من خير معجّل فمن علله الطمع و لو في نفع مؤجّل و منها العصبيّة و الحميّة و منها استقرار العادة و منها غير ذلك.
و لا دليل على انتفاء جميع هذه العلل عن جميع من آمن بالنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم بمكّة قبل الهجرة و قد نقل عن بعضهم أنّه آمن ثمّ رجع أو آمن عن ريب ثمّ صلح.
على أنّه تعالى يقول:( وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ فَإِذا أُوذِيَ فِي اللهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذابِ اللهِ وَ لَئِنْ جاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَ وَ لَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِما فِي صُدُورِ الْعالَمِينَ وَ لَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْمُنافِقِينَ ) العنكبوت: 11.
و الآيتان في سورة مكّيّة و هي سورة العنكبوت، و هما ناطقتان بوجود النفاق فيها و مع الغضّ عن كون السورة مكّيّة فاشتمال الآية على حديث الإيذاء في الله
و الفتنة أصدق شاهد على نزول الآيتين بمكّة فلم يكن بالمدينة إيذاء في الله و فتنة، و اشتمال الآية على قوله:( وَ لَئِنْ جاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ ) إلخ لا يدلّ على النزول بالمدينة فللنصر مصاديق اُخرى غير الفتح المعجّل.
و احتمال أن يكون المراد بالفتنة ما وقعت بمكّة بعد الهجرة غير ضائر فإنّ هؤلاء المفتونين بمكّة بعد الهجرة إنّما كانوا من الّذين آمنوا بالنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم قبل الهجرة و إن اُوذوا بعدها.
و على مثل ذلك ينبغي أن يحمل قوله تعالى:( وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلى حَرْفٍ فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ ) الحجّ: 11 إن كان المراد بالفتنة العذاب و إن كانت السورة مدنيّة.
و قوله:( كَذلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ ) الإشارة بذلك إلى مضمون قوله:( وَ ما جَعَلْنا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً ) إلخ.
و قوله:( وَ ما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ) علّق تعالى العلم المنفيّ بالجنود - و هي الجموع الغليظة الّتي خلقهم وسائط لإجراء أوامره - لا بخصوص عدّتهم فأفاد بإطلاقه أنّ العلم بحقيقتهم و خصوصيّات خلقتهم و عدّتهم و ما يعملونه من عمل و دقائق الحكمة في جميع ذلك يختصّ به تعالى لا يشاركه فيه أحد، فليس لأحد أن يستقلّ عدّتهم أو يستكثر أو يطعن في شيء ممّا يرجع إلى صفاتهم و هو جاهل بها.
و قوله:( وَ ما هِيَ إِلَّا ذِكْرى لِلْبَشَرِ ) الضمير راجع إلى ما تقدّم من قوله:( عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ ) و تأنيثه لتأنيث الخبر، و المعنى أنّ البشر لا سبيل لهم إلى العلم بجنود ربّك و إنّما أخبرنا عن خزنة النار أنّ عدّتهم تسعة عشر ليكون ذكرى لهم يتّعظون بها.
و قيل: الضمير للجنود، و قيل: لسقر، و قيل للسورة، و قيل: لنار الدنيا و هو أسخف الأقوال.
و في الآية دلالة على أنّ الخطابات القرآنيّة لعامّة البشر.
( بحث روائي)
في تفسير القمّيّ في قوله تعالى:( فَإِذا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ - إلى قوله -وَحِيداً ) فإنّها نزلت في الوليد بن المغيرة و كان شيخاً كبيراً مجرّباً من دهاة العرب، و كان من المستهزئين برسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم .
و كان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم يقعد في الحجر و يقرأ القرآن فاجتمعت قريش إلى الوليد بن المغيرة فقالوا: يا أبا عبد شمس ما هذا الّذي يقول محمّد؟ أ شعر هو أم كهانة أم خطب؟ فقال: دعوني أسمع كلامه فدنا من رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فقال: يا محمّد أنشدني من شعرك قال: ما هو شعر و لكنّه كلام الله الّذي ارتضاه لملائكته و أنبيائه و رسله فقال: اُتل عليّ منه شيئاً!
فقرأ عليه رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم حم السجدة فلمّا بلغ قوله:( فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَ ثَمُودَ ) قال: فاقشعرّ الوليد و قامت كلّ شعرة في رأسه و لحيته، و مرّ إلى بيته و لم يرجع إلى قريش من ذلك.
فمشوا إلى أبي جهل فقالوا: يا أبا الحكم إنّ أبا عبد شمس صبا إلى دين محمّد أ ما تراه لم يرجع إلينا فغدا أبو جهل إلى الوليد فقال: يا عمّ نكست رؤسنا و فضحتنا و أشمتّ بنا عدوّنا و صبوت إلى دين محمّد، فقال: ما صبوت إلى دينه و لكنّي سمعت كلاماً صعباً تقشعرّ منه الجلود فقال له أبوجهل: أ خطب هو؟ قال: لا إنّ الخطب كلام متّصل و هذا كلام منثور و لا يشبه بعضه بعضاً. قال: أ فشعر هو؟ قال: لا أمّا إنّي لقد سمعت أشعار العرب بسيطها و مديدها و رملها و رجزها و ما هو بشعر. قال: فما هو؟ قال: دعني اُفكّر فيه.
فلمّا كان من الغد قالوا له: يا أعبد شمس ما تقول فيما قلناه؟ قال: قولوا: هو سحر فإنّه آخذ بقلوب الناس فأنزل على رسولهصلىاللهعليهوآلهوسلم في ذلك:( ذَرْنِي وَ مَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً ) .
و إنّما سمّي وحيداً لأنّه قال لقريش: أنا أتوحّد لكسوة البيت سنة و عليكم في جماعتكم سنة، و كان له مال كثير و حدائق، و كان له عشر بنين بمكّة، و كان له عشرة عبيد عند كلّ عبد ألف دينار يتّجر بها و تلك القنطار في ذلك الزمان، و يقال: إنّ القنطار جلد ثور مملوّء ذهباً.
و في الدرّ المنثور، أخرج الحاكم و صحّحه و البيهقيّ في الدلائل من طريق عكرمة عن ابن عبّاس أنّ الوليد بن المغيرة جاء إلى النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم فقرأ عليه القرآن فكأنّه رقّ له فبلغ ذلك أباجهل فأتاه فقال: يا عمّ إنّ قومك يريدون أن يجعلوا لك مالاً ليعطوه لك فإنّك أتيت محمّداً لتصيب ممّا عنده. قال: قد علمت قريش أنّي من أكثرها مالاً.
قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنّك منكر أو أنّك كاره له، قال: و ما ذا أقول فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر منّي لا برجزه و لا بقصيده و لا بأشعار الجنّ و الله ما يشبه الّذي يقول شيئاً من هذا، و و الله إنّ لقوله الّذي يقوله حلاوة و إنّ عليه لطلاوة، و إنّه لمثمر أعلاه، و مغدق أسفله، و إنّه ليعلو و لا يعلى، و إنّه ليحطم ما تحته.
قال: لا يرضى عنك قومك حتّى تقول فيه قال: دعني حتّى اُفكّر فلمّا فكّر قال ما هو إلّا سحر يؤثر يأثره عن غيره فنزلت:( ذَرْنِي وَ مَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً ) .
و في المجمع، روى العيّاشيّ بإسناده عن زرارة و حمران و محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله و أبي جعفرعليهماالسلام أنّ الوحيد ولد الزنا. قال زرارة: ذكر لأبي جعفرعليهالسلام عن أحد بني هشام أنّه قال في خطبته: أنا ابن الوحيد فقال: ويله لو علم ما الوحيد ما فخر بها فقلنا له، و ما هو؟ قال، من لا يعرف له أب.
و في الدرّ المنثور، أخرج أحمد و ابن المنذر و الترمذيّ و ابن أبي الدنيا في صفة النار و ابن جرير و ابن أبي حاتم و ابن حيّان و الحاكم و صحّحه و البيهقيّ في البعث
عن أبي سعيد الخدريّ عن النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم قال، الصعود جبل في النار يصعد فيه الكافر سبعين خريفاً ثمّ يهوي و هو كذلك فيه أبداً.
و في تفسير القمّيّ في قوله تعالى،( ثُمَّ عَبَسَ ) قال، عبس وجهه( وَ بَسَرَ ) قال، ألقى شدقه(1) .
____________________
(1) زاوية الفم.
( سورة المدّثّر الآيات 32 - 48)
كَلَّا وَالْقَمَرِ ( 32 ) وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ( 33 ) وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ( 34 ) إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ ( 35 ) نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ( 36 ) لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ( 37 ) كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ( 38 ) إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ( 39 ) فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ( 40 ) عَنِ الْمُجْرِمِينَ ( 41 ) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ( 42 ) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ( 43 ) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ( 44 ) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ( 45 ) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ( 46 ) حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ ( 47 ) فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ( 48 )
( بيان)
في الآيات تنزيه للقرآن الكريم عمّا رموه به، و تسجيل أنّه إحدى الآيات الإلهيّة الكبرى فيه إنذار البشر كافّة و في اتّباعه فكّ نفوسهم عن رهانة أعمالهم الّتي تسوقهم إلى سقر.
قوله تعالى: ( كَلَّا ) ردع و إنكار لما تقدّم قال في الكشّاف: إنكار بعد أن جعلها ذكرى أن يكون لهم ذكرى لأنّهم لا يتذكّرون، أو ردع لمن ينكر أن يكون إحدى الكبر نذيراً. انتهى. فعلى الأوّل إنكار لما تقدّم و على الثاني ردع لما سيأتي، و هناك وجه آخر سيوافيك.
قوله تعالى: ( وَ الْقَمَرِ وَ اللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَ الصُّبْحِ إِذا أَسْفَرَ ) قسم بعد قسم، و إدبار الليل مقابل إقباله، و إسفار الصبح انجلاؤه و انكشافه.
قوله تعالى: ( إِنَّها لَإِحْدَى الْكُبَرِ ) ذكروا أنّ الضمير لسقر، و الكبر جمع كبري، و المراد بكون سقر إحدى الكبر أنّها إحدى الدواهي الكبر لا يعادلها غيرها من الدواهي كما يقال: هو أحد الرجال أي لا نظير له بينهم، و الجملة جواب للقسم.
و المعنى اُقسم بكذا و كذا إنّ سقر لإحدى الدواهي الكبر - أكبرها - إنذاراً للبشر.
و لا يبعد أن يكون( كَلَّا ) ردعاً لقوله في القرآن:( إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هذا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ) و يكون ضمير( إِنَّها ) للقرآن بما أنّه آيات أو من باب مطابقة اسم إنّ لخبرها.
و المعنى: ليس كما قال اُقسم بكذا و كذا أنّ القرآن - آياته - لإحدى الآيات الإلهيّة الكبرى إنذاراً للبشر.
و قيل: الجملة( إِنَّها لَإِحْدَى الْكُبَرِ ) تعليل للردع، و القسم معترض للتأكيد لا جواب له أو جوابه مقدّر يدلّ عليه كلّا.
قوله تعالى: ( نَذِيراً لِلْبَشَرِ ) مصدر بمعنى الإنذار منصوب للتمييز، و قيل: حال ممّا يفهم من سياق قوله:( إِنَّها لَإِحْدَى الْكُبَرِ ) أي كبرت و عظمت حالكونها إنذاراً أي منذرة.
و قيل فيه وجوه اُخر لا يعبأ بها كقول بعضهم: إنّه صفة للنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم و الآية متّصلة بأوّل السورة و التقدير قم نذيراً للبشر فأنذر، و قول بعضهم: صفة له تعالى.
قوله تعالى: ( لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ) تعميم للإنذار و( لِمَنْ شاءَ ) بدل من البشر، و( أَنْ يَتَقَدَّمَ ) إلخ مفعول( شاءَ ) و المراد بالتقدّم و التأخّر: الاتّباع للحقّ و مصداقه الإيمان و الطاعة، و عدم الاتّباع و مصداقه الكفر و المعصية.
و المعنى: نذيراً لمن اتّبع منكم الحقّ و لمن لم يتّبع أي لجميعكم من غير استثناء.
و قيل:( أَنْ يَتَقَدَّمَ ) في موضع الرفع على الابتداء و( لِمَنْ شاءَ ) خبره كقولك لمن توضّأ أن يصلّي، و المعنى مطلق لمن شاء التقدّم أو التأخّر أن يتقدّم أو يتأخّر، و
هو كقوله.( فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ ) و المراد بالتقدّم و التأخّر السبق إلى الخير و التخلّف عنه انتهى.
قوله تعالى: ( كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ) الباء بمعنى مع أو للسببيّة أو للمقابلة و( رَهِينَةٌ ) بمعنى الرهن على ما ذكره الزمخشريّ قال في الكشّاف: رهينة ليست بتأنيث رهين في قوله:( كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ ) لتأنيث النفس لأنّه لو قصدت لقيل: رهين لأنّ فعيلاً بمعنى مفعول يستوي فيه المذكّر و المؤنّث، و إنّما هي اسم بمعنى الرهن كالشتيمة بمعنى الشتم كأنّه قيل: كلّ نفس بما كسبت رهن. انتهى.
و كأنّ العناية في عدّ كلّ نفس رهينة أنّ لله عليها حقّ العبوديّة بالإيمان و العمل الصالح فهي رهينة محفوظة محبوسة عند الله حتّى توفّي دينه و تؤدّي حقّه تعالى فإن آمنت و صلحت فكّت و اُطلقت، و إن كفرت و أجرمت و ماتت على ذلك كانت رهينة محبوسة دائماً، و هذا غير كونها رهين عملها ملازمة لما اكتسبت من خير و شرّ كما تقدّم في قوله تعالى:( كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ ) الطور: 21.
و الآية في مقام بيان وجه التعميم المستفاد من قوله:( نَذِيراً لِلْبَشَرِ لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ) فإنّ كون النفس الإنسانيّة رهينة بما كسبت يوجب على كلّ نفس أن تتّقي النار الّتي ستحبس فيها إن أجرمت و لم تتّبع الحقّ.
قوله تعالى: ( إِلَّا أَصْحابَ الْيَمِينِ ) هم الّذين يؤتون كتابهم بأيمانهم يوم الحساب و هم أصحاب العقائد الحقّة و الأعمال الصالحة من متوسّطي المؤمنين، و قد تكرّر ذكرهم و تسميتهم بأصحاب اليمين في مواضع من كلامه تعالى، و على هذا فالاستثناء متّصل.
و المتحصّل من مجموع المستثنى منه و المستثنى انقسام النفوس ذوات الكسب إلى نفوس رهينة بما كسبت و هي نفوس المجرمين، و نفوس مفكوكة من الرهن مطلقة و هي نفوس أصحاب اليمين، و أمّا السابقون المقرّبون و هم الّذين ذكرهم الله في مواضع من كلامه و عدّهم ثالثة الطائفتين و غيرهما كما في قوله تعالى:( وَ كُنْتُمْ أَزْواجاً ثَلاثَةً
- إلى أن قال -وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ) الواقعة: 11، فهؤلاء قد استقرّوا في مستقرّ العبوديّة لا يملكون نفساً و لا عمل نفس فنفوسهم لله و كذلك أعمالهم فلا يحضرون و لا يحاسبون قال تعالى:( فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ ) الصافّات: 128، فهم خارجون عن المقسم رأساً.
و عن بعضهم تفسير أصحاب اليمين بالملائكة، و عن بعضهم التفسير بأطفال المسلمين و عن بعضهم أنّهم الّذين كانوا عن يمين آدم يوم الميثاق، و عن بعضهم أنّهم الّذين سبقت لهم من الله الحسنى، و هي وجوه ضعيفة غير خفيّة الضعف.
قوله تعالى: ( فِي جَنَّاتٍ يَتَساءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ) ( فِي جَنَّاتٍ ) خبر لمبتدإ محذوف و تنوين جنّات للتعظيم، و التقدير هم في جنّات لا يدرك وصفها، و يمكن أن يكون حالاً من أصحاب اليمين.
و قوله:( يَتَساءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ) أي يتساءل جمعهم عن جمع المجرمين.
و قوله:( ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ) أي ما أدخلكم في سقر بيان لتساؤلهم من بيان الجملة بالجملة، أو بتقدير القول أي قائلين ما سلككم في سقر.
قوله تعالى: ( قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ) ضمير الجمع للمجرمين، و المراد بالصلاة التوجّه العبادي الخاصّ إلى الله سبحانه فلا يضرّه اختلاف الصلاة كمّاً و كيفاً باختلاف الشرائع السماويّة الحقّة.
قوله تعالى: ( وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ) المراد بإطعام المسكين الإنفاق على فقراء المجتمع بما يقوم به صلبهم و يرتفع به حاجتهم، و إطعام المسكين إشارة إلى حقّ الناس عملاً كما أنّ الصلاة إشارة إلى حقّ الله كذلك.
قوله تعالى: ( وَ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ ) المراد بالخوض الاشتغال بالباطل قولاً أو فعلاً و الغور فيه.
قوله تعالى: ( وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ) و هو يوم الجزاء فهذه خصال أربع من طبع المجرم أن يبتلي بها كلّاً أو بعضاً، و لمّا كان المجيب عن التساؤل جمع المجرمين صحّت نسبة الجميع إلى الجميع و إن كان بعضهم مبتلى ببعضها دون بعض.
قوله تعالى: ( حَتَّى أَتانَا الْيَقِينُ ) قيد للتكذيب، و فسّروا اليقين بالموت لكونه ممّا لا شكّ فيه فالمعنى و كنّا في الدنيا نكذّب بيوم الجزاء حتّى أتانا الموت فانقطعت به الحياة الدنيا أي كنّا نكذّب به ما دامت الحياة.
و قيل: المراد به اليقين الحاصل بحقّيّة يوم الجزاء بمشاهدة آيات الآخرة و معاينة الحياة البرزخيّة حين الموت و بعده، و هو معنى حسن.
قوله تعالى: ( فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ ) تقدّم في بحث الشفاعة أنّ في الآية دلالة على أنّ هناك شافعين يشفعون فيشفّعون لكن لا تنفع هؤلاء شفاعتهم لأنّهم محرومون من نيلها.
و قد أوردنا جملة من أخبار الشفاعة في الجزء الأوّل من الكتاب.
( سورة المدّثّر الآيات 49 - 56)
فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ( 49 ) كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ ( 50 ) فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ ( 51 ) بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ( 52 ) كَلَّا بَل لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ( 53 ) كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ( 54 ) فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ( 55 ) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ( 56 )
( بيان)
في معنى الاستنتاج ممّا تقدّم من الوعيد و الوعد اُورد في صورة التعجّب من إعراضهم عن تذكرة القرآن و تنفّرهم عن الحقّ الصريح كأنّه قيل: فإذا كان كذلك فعليهم أن يجيبوا دعوة الحقّ و يتذكّروا بالتذكرة فمن العجب أنهم معرضون عن ذلك كلّا بل لا يؤمنون بالرسالة و يريد كلّ امرئ منهم أن ينزل عليه كتاب من الله. كلّا بل لا يخافون الآخرة فلا يرتدعون عن وعيد.
ثمّ يعرض عليهم التذكرة عرضاً فهم على خيرة من القبول و الردّ فإن شاؤا قبلوا و إن شاؤا ردّوا، لكن عليهم أن يعلموا أنّهم غير مستقلّين في مشيّتهم و ليسوا بمعجزين لله سبحانه فليس لهم أن يذكروا إلّا أن يشاء الله، و حكم القدر جار فيهم البتّة.
قوله تعالى: ( فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ) تفريع على ما تقدّم من التذكرة و الموعظة، و الاستفهام للتعجيب، و( لَهُمْ ) متعلّق بمحذوف و التقدير فما كان لهم: و( مُعْرِضِينَ ) حال من ضمير( لَهُمْ ) و( عَنِ التَّذْكِرَةِ ) متعلّق بمعرضين.
و المعنى: فإذا كان كذلك فأيّ شيء كان - عرض - للمشركين الّذين يكذّبون بتذكرة القرآن حال كونهم معرضين عنها أي كان من الواجب عليهم أن يصدّقوا و يؤمنوا لكنّهم أعرضوا عنها و هو من العجب.
قوله تعالى: ( كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ) تشبيه لهم من حيث حالهم في الإعراض عن التذكرة، و الحمر جمع حمار، و المراد الحمر الوحشيّة و الاستنفار بمعنى النفرة و القسورة الأسد و الصائد، و قد فسّر بكلّ من المعنيين.
و المعنى: معرضين عن التذكرة كأنّهم حمر وحشيّة نفرت من أسد أو من الصائد.
قوله تعالى: ( بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتى صُحُفاً مُنَشَّرَةً ) المراد بالصحف المنشّرة الكتاب السماويّ المشتمل على الدعوة الحقّة.
و في الكلام إضراب عمّا ذكر من إعراضهم، و المعنى ليس إعراضهم عن التذكرة لمجرّد النفرة بل يريد كلّ امرئ منهم أن ينزّل عليه كتاب من عند الله مشتمل على ما تشتمل عليه دعوة القرآن.
و هذه النسبة إليهم كناية عن استكبارهم على الله سبحانه أنّهم إنّما يقبلون دعوته و لا يردّونها لو دعا كلّ واحد منهم بإنزال كتاب سماويّ إليه مستقلّاً و أمّا الدعوة من طريق الرّسالة فليسوا يستجيبونها و إن كانت حقّة مؤيّدة بالآيات البيّنة.
فالآية في معنى ما حكاه الله سبحانه من قولهم:( لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتى مِثْلَ ما أُوتِيَ رُسُلُ اللهِ ) الأنعام: 124، و في معنى قول الاُمم لرسلهم:( إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا ) على ما قرّرنا من حجّتهم على نفي رسالة الرسل.
و قيل: إنّ الآية في معنى قولهم للنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم الّذي حكاه الله في قوله:( وَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ ) إسراء: 93.
و يدفعه أنّ مدلول الآية أن ينزل على كلّ واحد منهم صحف منشّرة غير ما ينزل على غيره لا نزول كتاب واحد من السماء على النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم يقرؤه الجميع كما هو مدلول آية الإسراء.
و قيل: المراد نزول كتب من السماء عليهم بأسمائهم أن آمنوا بمحمّدصلىاللهعليهوآلهوسلم .
و قيل: المراد أن ينزل عليهم كتب من السماء بالبراءة من العذاب و إسباغ النعمة حتّى يؤمنوا و إلّا بقوا على كفرهم و قيل غير ذلك.
و هي جميعاً معان بعيدة من السياق و التعويل على ما تقدّم.
قوله تعالى: ( كَلَّا بَلْ لا يَخافُونَ الْآخِرَةَ ) ردع لهم بما يريدونه من نزول كتاب سماويّ على كلّ واحد منهم فإنّ دعوة الرسالة مؤيّدة بآيات بيّنة و حجج قاطعة لا تدع ريباً لمرتاب فالحجّة تامّة قائمة على الرسول و غيره على حدّ سواء من غير حاجة إلى أن يؤتى كلّ واحد من الناس المدعوّين صحفاً منشّرة.
على أنّ الرسالة تحتاج من طهارة الذات و صلاحيّة النفس إلى ما يفقده نفوس سائر الناس كما هو مدلول جوابه تعالى في سورة الأنعام عن قولهم:( لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتى مِثْلَ ما أُوتِيَ رُسُلُ اللهِ ) بقوله:( اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ ) .
و قوله:( بَلْ لا يَخافُونَ الْآخِرَةَ ) إضراب عن قوله:( يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ ) إلخ، و المراد أنّ اقتراحهم نزول كتاب على كلّ امرئ منهم قول ظاهريّ منهم يريدون به صرف الدعوة عن أنفسهم، و السبب الحقيقيّ لكفرهم و تكذيبهم بالدعوة أنّهم لا يخافون الآخرة، و لو خافوها لآمنوا و لم يقترحوا آية بعد قيام الحجّة بظهور الآيات البيّنات.
قوله تعالى: ( كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ) ردع ثان لاقتراحهم نزول كتاب سماويّ لكلّ امرئ منهم، و المعنى لا ننزل كتاباً كذلك إنّ القرآن تذكرة و موعظة نعظهم به لا نريد به أزيد من ذلك، و أثر ذلك ما أعدّ للمطيع و العاصي عندنا من الجزاء.
قوله تعالى: ( فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ ) أي فمن شاء اتّعظ به فإنّما هي دعوة في ظرف الاختيار من غير إكراه.
قوله تعالى: ( وَ ما يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوى وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ) دفع لما يمكن أن يتوهّموه من قوله تعالى:( فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ ) أنّ الأمر إليهم و أنّهم
مستقلّون في إرادتهم و ما يترتّب عليها من أفعالهم فإن لم يشاؤا الذكر و لم يذكروا غلبوه تعالى فيما أراد و أعجزوه فيما شاء من ذكرهم.
و المحصّل من الدفع أنّ حكم القدر جاء في أفعالهم كغيرها من الحوادث، و تذكّرهم إن تذكّروا و إن كان فعلاً اختياريّاً صادراً عنهم باختيارهم من غير إكراه فالمشيّة الإلهيّة متعلّقة به بما هو اختياريّ بمعنى أنّ الله تعالى يريد بإرادة تكوينيّة أن يفعل الإنسان الفعل الفلانيّ بإرادته و اختياره فالفعل اختياريّ ممكن بالنسبة إلى الإنسان و هو بعينه متعلّق الإرادة الإلهيّة ضروريّ التحقّق بالنسبة إليها و لولاها لم يتحقّق.
و قوله:( هُوَ أَهْلُ التَّقْوى وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ) أي أهل لأن يتّقى منه لأنّ له الولاية المطلقة على كلّ شيء، و بيده سعادة الإنسان و شقاوته، و أهل لأن يغفر لمن اتّقاه لأنّه غفور رحيم.
و الجملة أعني قوله:( هُوَ أَهْلُ التَّقْوى وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ) صالحة لتعليل ما تقدّم من الدعوة في قوله:( إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ ) و هو ظاهر، و لتعليل قوله:( وَ ما يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ ) فإنّ كونه تعالى أهل التقوى و أهل المغفرة لا يتمّ إلّا بكونه ذا إرادة نافذة فيهم سارية في أعمالهم فليسوا بمخلّين و ما يهوونه و هم معجزون لله بتمرّدهم و استكبارهم.
( بحث روائي)
في تفسير القمّيّ، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرعليهالسلام في قوله تعالى:( بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتى صُحُفاً مُنَشَّرَةً ) و ذلك أنّهم قالوا: يا محمّد قد بلغنا أنّ الرجل من بني إسرائيل كان يذنب الذنب فيصبح و ذنبه مكتوب عند رأسه و كفّارته.
فنزل جبرئيل على رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم و قال: يسألك قومك سنّة بني إسرائيل
في الذنوب فإن شاؤا فعلنا ذلك بهم و أخذناهم بما كنّا نأخذ بني إسرائيل فزعموا أنّ رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم كره ذلك لقومه.
أقول: و القصّة لا تلائم لحن الآية و الرواية لا تخلو من إيماء إلى ضعف القصّة.
و في الدرّ المنثور، أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن السدّيّ عن أبي صالح قال: قالوا: إن كان محمّد صادقاً فليصبح تحت رأس كلّ رجل منّا صحيفة فيها براءته و أمنته من النار فنزلت:( بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتى صُحُفاً مُنَشَّرَةً ) .
أقول: سياق الآيات و ما فيها من الردع لا يلائم القصّة.
و فيه، أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن مجاهد( بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتى صُحُفاً مُنَشَّرَةً ) قال: إلى فلان بن فلان من ربّ العالمين يصبح عند رأس كلّ رجل صحيفة موضوعة يقرؤها.
أقول: ما في الرواية يقبل الانطباق على الرواية السابقة و على ما قدّمناه من معنى الآية.
و فيه، أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن قتادة في قوله تعالى:( بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتى صُحُفاً مُنَشَّرَةً ) قال: قد قال قائلون من الناس لمحمّدصلىاللهعليهوآلهوسلم إن سرّك أن نتابعك فأتنا بكتاب خاصّة يأمرنا باتّباعك.
أقول: الرواية قابلة التطبيق لما في تفسير الآية من القول بأنّ الآية في معنى قوله تعالى:( وَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ ) الآية و قد تقدّم ما فيه.
و في تفسير القمّيّ في قوله تعالى:( هُوَ أَهْلُ التَّقْوى وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ) قال: هو أهل أن يتّقى و أهل أن يغفر.
و في التوحيد، بإسناده إلى أبي بصير عن أبي عبداللهعليهالسلام في قول الله عزّوجلّ:( هُوَ أَهْلُ التَّقْوى وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ) قال: قال الله عزّوجلّ: أنا أهل أن اُتّقى و لا يشرك بي عبدي شيئاً و أنا أهل إن لم يشرك بي عبدي شيئاً أن اُدخله الجنّة.
و قال: إنّ الله تبارك و تعالى أقسم بعزّته و جلاله أن لا يعذّب أهل توحيده بالنار.
و في الدرّ المنثور، أخرج ابن مردويه عن عبدالله بن دينار قال: سمعت أباهريرة و ابن عمر و ابن عبّاس يقولون: سئل رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم عن قول الله:( هُوَ أَهْلُ التَّقْوى وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ) قال: يقول الله: أنا أهل أن اُتّقى فلا يُجعل معي شريك فإذا اتّقيت و لم يجعل معي شريك فأنا أهل أن أغفر ما سوى ذلك.
أقول: و في معناه غير واحد من الروايات عنهصلىاللهعليهوآلهوسلم .
( سورة القيامة مكّيّة و هي أربعون آية)
( سورة القيامة الآيات 1 - 15)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ( 1 ) وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ( 2 ) أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ ( 3 ) بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ ( 4 ) بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ( 5 ) يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ( 6 ) فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ( 7 ) وَخَسَفَ الْقَمَرُ ( 8 ) وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ( 9 ) يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ ( 10 ) كَلَّا لَا وَزَرَ ( 11 ) إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ( 12 ) يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ( 13 ) بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ( 14 ) وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ( 15 )
( بيان)
يطوف بيان السورة حول القيامة الكبرى فتنبئ بوقوع يوم القيامة أوّلاً ثمّ تصفه ببعض أشراطه تارة، و بإجمال ما يجري على الإنسان اُخرى، و ينبئ أنّ المساق إليه يبدأ من يوم الموت، و تختتم بالاحتجاج على القدرة على الإعادة بالقدرة على الابتداء.
و السورة مكّيّة بشهادة سياق آياتها.
قوله تعالى: ( لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ ) إقسام بيوم القيامة سواء قيل بكون( لا أُقْسِمُ ) كلمة قسم أو بكون لا زائدة أو نافية على اختلاف الأقوال.
قوله تعالى: ( وَ لا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ) إقسام ثان على ما يقتضيه السياق و مشاكلة اللفظ فلا يعبأ بما قيل: أنّه نفي الأقسام و ليس بقسم، و المراد اُقسم بيوم
القيامة و لا اُقسم بالنفس اللوّامة.
و المراد بالنفس اللوّامة نفس المؤمن الّتي تلومه في الدنيا على المعصية و التثاقل في الطاعة و تنفعه يوم القيامة.
و قيل: المراد به النفس الإنسانيّة أعمّ من المؤمنة الصالحة و الكافرة الفاجرة فإنّها تلوم الإنسان يوم القيامة أمّا الكافرة فإنّها تلومه على كفره و فجوره، و أمّا المؤمنة فإنّها تلومه على قلّة الطاعة و عدم الاستكثار من الخير.
و قيل. المراد نفس الكافر الّتي تلومه يوم القيامة على ما قدّمت من كفر و معصية قال تعالى:( وَ أَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ ) يونس: 54.
و لكلّ من الأقوال وجه.
و جواب القسم محذوف يدلّ عليه الآيات التالية، و التقدير ليبعثنّ، و إنّما حذف للدلالة على تفخيم اليوم و عظمة أمره قال تعالى:( ثَقُلَتْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ) الأعراف: 187 و قال:( إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكادُ أُخْفِيها لِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما تَسْعى ) طه: 15 و قال:( عَمَّ يَتَساءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ ) النبأ: 1.
قوله تعالى: ( أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ ) الحسبان الظنّ، و جمع العظام كناية عن الإحياء بعد الموت، و الاستفهام للتوبيخ، و المعنى ظاهر.
قوله تعالى: ( بَلى قادِرِينَ عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ ) أي بلى نجمعها( و قادِرِينَ ) حال من فاعل مدخول بلى المقدّر، و البنان أطراف الأصابع و قيل: الأصابع و تسوية البنان تصويرها على ما هي عليها من الصور، و المعنى بلى نجمعها و الحال أنّا قادرون على أن نصوّر بنانه على صورها الّتي هي عليها بحسب خلقنا الأوّل.
و تخصيص البنان بالذكر - لعلّه - للإشارة إلى عجيب خلقها بما لها من الصور و خصوصيّات التركيب و العدد تترتّب عليها فوائد جمّة لا تكاد تحصى من أنواع القبض و البسط و الأخذ و الردّ و سائر الحركات اللطيفة و الأعمال الدقيقة و الصنائع الظريفة الّتي يمتاز بها الإنسان من سائر الحيوان مضافاً إلى ما عليها من الهيئات و الخطوط الّتي لا يزال ينكشف للإنسان منها سرّ بعد سرّ.
و قيل: المراد بتسوية البنان جعل أصابع اليدين و الرجلين مستوية شيئاً واحداً من غير تفريق كخفّ البعير و حافر الحمار، و المعنى قادرين على أن نجعلها شيئاً واحداً فلا يقدر الإنسان حينئذ على ما يقدر عليه مع تعدّد الأصابع من فنون الأعمال، و الوجه المتقدّم أرجح.
قوله تعالى: ( بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسانُ لِيَفْجُرَ أَمامَهُ ) قال الراغب: الفجر شقّ الشيء شقّاً واسعاً. قال: و الفجور شقّ ستر الديانة يقال: فجر فجوراً فهو فاجر و جمعه فجّار و فجرة. انتهى، و أمام ظرف مكان أستعير لمستقبل الزمان، و المراد من فجوره أمامه فجوره مدى عمره و ما دام حيّاً، و ضمير( أَمامَهُ ) للإنسان.
و قوله:( لِيَفْجُرَ أَمامَهُ ) تعليل سادّ مسدّ معلّله و هو التكذيب بالبعث و الإحياء بعد الموت، و( بَلْ ) إضراب عن حسبانه عدم البعث و الإحياء بعد الموت.
و المعنى: أنّه لا يحسب أن لن نجمع عظامه بل يريد أن يكذّب بالبعث ليفجر مدى عمره إذ لا موجب للإيمان و التقوى لو لم يكن هناك بعث للحساب و الجزاء.
هذا ما يعطيه السياق في معنى الآية، و لهم وجوه اُخر ذكروها في معنى الآية بعيدة لا تلائم السياق أغمضنا عن ذكرها.
و ذكر الإنسان في الآية من وضع الظاهر موضع الضمير و النكتة فيه زيادة التوبيخ و المبالغة في التقريع، و قد كرّر ذلك في الآية و ما يتلوها من الآيات أربع مرّات.
قوله تعالى: ( يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ ) الظاهر أنّه بيان لقوله:( بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسانُ لِيَفْجُرَ أَمامَهُ ) فيفيد التعليل و أنّ السائل في مقام التكذيب و السؤال سؤال تكذيب إذ من الواجب على من دعي إلى الإيمان و التقوى، و اُنذر بهذا النبإ العظيم مع دلالة الآيات البيّنة و قيام الحجج القاطعة أن يتّخذ حذره و يتجهّز بالإيمان و التقوى و يتهيّأ للقاء اليوم قريباً كان أو بعيداً فكلّ ما هو آت قريب لا أن يسأل متى تقوم الساعة؟ و أيّان يوم القيامة؟ فليس إلّا سؤال مكذّب مستهزئ.
قوله تعالى: ( فَإِذا بَرِقَ الْبَصَرُ وَ خَسَفَ الْقَمَرُ وَ جُمِعَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ ) ذكر
جملة من أشراط الساعة، و بريق البصر تحيّره في إبصاره و دهشته، و خسوف القمر زوال نوره.
قوله تعالى: ( يَقُولُ الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ ) أي أين موضع الفرار، و قوله:( أَيْنَ الْمَفَرُّ ) مع ظهور السلطنة الإلهيّة له و علمه بأن لا مفرّ و لا فرار يومئذ من باب ظهور ملكاته يومئذ فقد كان في الدنيا يسأل عن المفرّ إذا وقع في شدّة أو هدّدته مهلكة و ذلك كإنكارهم الشرك يومئذ و حلفهم كذباً قال تعالى:( ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا وَ اللهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ ) الأنعام: 23، و قال:( يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَما يَحْلِفُونَ لَكُمْ ) المجادلة: 18.
قوله تعالى: ( كَلَّا لا وَزَرَ ) ردع عن طلبهم المفرّ، و الوزر الملجأ من جبل أو حصن أو غيرهما، و هو من كلامه تعالى لا من تمام كلام الإنسان.
قوله تعالى: ( إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ) الخطاب للنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم ، و تقديم( إِلى رَبِّكَ ) و هو متعلّق بقوله:( الْمُسْتَقَرُّ ) يفيد الحصر فلا مستقرّ إلى غيره فلا وزر و لا ملجأ يلتجأ إليه فيمنع عنه.
و ذلك أنّ الإنسان سائر إليه تعالى كما قال:( يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ ) الانشقاق: 6 و قال:( إِنَّ إِلى رَبِّكَ الرُّجْعى ) العلق: 8 و قال:( وَ أَنَّ إِلى رَبِّكَ الْمُنْتَهى ) النجم: 42، فهو ملاقي ربّه راجع و منته إليه لا حاجب يحجبه عنه و لا مانع يمنعه منه و أمّا الحجاب الّذي يشير إليه قوله:( كَلَّا بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ) المطفّفين: 15 فسياق الآيتين يعطي أنّ المراد به حجاب الحرمان من الكرامة لا حجاب الجهل أو الغيبة.
و يمكن أن يكون المراد بكون مستقرّه إليه رجوع أمر ما يستقرّ فيه من سعادة أو شقاوة و جنّة أو نار إلى مشيّته تعالى فمن شاء جعله في الجنّة و هم المتّقون و من شاء جعله في النار و هم المجرمون قال تعالى:( يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ ) المائدة: 40.
و يمكن أن يراد به أنّ استقرارهم يومئذ إلى حكمه تعالى فهو النافذ فيهم لا غير قال تعالى:( كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ) القصص: 88.
قوله تعالى: ( يُنَبَّؤُا الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ بِما قَدَّمَ وَ أَخَّرَ ) المراد بما قدّم و أخّر ما عمله من حسنة أو سيّئة في أوّل عمره و آخره أو ما قدّمه على موته من حسنة أو سيّئة و ما أخّر من سنّة حسنة سنّها أو سنّة سيّئة فيثاب بالحسنات و يعاقب على السيّئات.
و قيل: المراد بما قدّم ما عمله من حسنة أو سيّئة فيثاب على الأوّل و يعاقب على الثاني، و بما أخّر ما تركه من حسنة أو سيّئة فيعاقب على الأوّل و يثاب على الثاني، و قيل، المراد ما قدّم من المعاصي و ما أخّر من الطاعات، و قيل، ما قدّم من طاعة الله و أخّر من حقّه فضيّعه، و قيل: ما قدّم من ماله لنفسه و ما ترك لورثته و هي وجوه ضعيفة بعيدة عن الفهم.
قوله تعالى: ( بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَ لَوْ أَلْقى مَعاذِيرَهُ ) إضراب عن قوله،( يُنَبَّؤُا الْإِنْسانُ ) إلخ، و البصيرة رؤية القلب و الإدراك الباطنيّ و إطلاقها على الإنسان من باب زيد عدل أو التقدير الإنسان ذو بصيرة على نفسه.
و قيل: المراد بالبصيرة الحجّة كما في قوله تعالى،( ما أَنْزَلَ هؤُلاءِ إِلَّا رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ بَصائِرَ ) إسراء: 102 و الإنسان نفسه حجّة على نفسه يومئذ حيث يسأل عن سمعه و بصره و فؤاده و يشهد عليه سمعه و بصره و جلده و يتكلّم يداه و رجلاه، قال تعالى:( إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا ) إسراء: 36، و قال( شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ أَبْصارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ ) حم السجدة: 20. و قال،( وَ تُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ ) يس: 65.
و قوله:( وَ لَوْ أَلْقى مَعاذِيرَهُ ) المعاذير جمع معذرة و هي ذكر موانع تقطع عن الفعل المطلوب، و المعنى هو ذو بصيرة على نفسه و لو جادل عن نفسه و اعتذر بالمعاذير لصرف العذاب عنها.
و قيل: المعاذير جمع معذار و هو الستر، و المعنى و إن أرخى الستور ليخفي ما عمل فإنّ نفسه شاهدة عليه و مآل الوجهين واحد.
( بحث روائي)
في تفسير القمّيّ في قوله تعالى:( وَ لا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ) قال: نفس آدم الّتي عصت فلامها الله عزّوجلّ.
أقول: و في انطباقها على الآية خفاء.
و فيه، في قوله:( بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسانُ لِيَفْجُرَ أَمامَهُ ) قال: يقدّم الذنب و يؤخّر التوبة و يقول: سوف أتوب.
و فيه، في قوله:( فَإِذا بَرِقَ الْبَصَرُ ) قال: يبرق البصر فلا يقدر أن يطرف.
و فيه، في قوله تعالى:( بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَ لَوْ أَلْقى مَعاذِيرَهُ ) قال: يعلم ما صنع و إن اعتذر.
و في الكافي، بإسناده عن عمر بن يزيد قال: إنّي لأتعشّى مع أبي عبداللهعليهالسلام و تلا هذه الآية( بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَ لَوْ أَلْقى مَعاذِيرَهُ ) ، ثمّ قال: يا أبا حفص ما يصنع الإنسان أن يعتذر إلى الناس بخلاف ما يعلم الله منه؟ إنّ رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم كان يقول: من أسرّ سريرة ألبسه الله رداها إن خيراً فخير و إن شرّاً فشرّ.
و في المجمع، و روى العيّاشيّ بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: ما يصنع أحدكم أن يظهر حسناً و يستر سيّئاً؟ أ ليس إذا رجع إلى نفسه يعلم أنّه ليس كذلك؟ و الله سبحانه يقول:( بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) إنّ السريرة إذا صلحت قويت العلانية.
أقول: و رواه في اُصول الكافي، بإسناده عن فضل أبي العبّاس عنهعليهالسلام .
و فيه، عن العيّاشيّ عن زرارة قال، سألت أباعبداللهعليهالسلام ما حدّ المرض الّذي يفطر صاحبه؟ قال،( بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) هو أعلم بما يطيق.
أقول: و رواه في الفقيه، أيضاً.
( سورة القيامة الآيات 16 - 40)
لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ( 16 ) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ( 17 ) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ( 18 ) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ( 19 ) كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ( 20 ) وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ( 21 ) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ( 22 ) إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ( 23 ) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ( 24 ) تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ( 25 ) كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ( 26 ) وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ( 27 ) وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ( 28 ) وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ( 29 ) إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ( 30 ) فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ( 31 ) وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ( 32 ) ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ ( 33 ) أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ( 34 ) ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ( 35 ) أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ( 36 ) أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ( 37 ) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ( 38 ) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ( 39 ) أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ( 40 )
( بيان)
تتمّة صفة يوم القيامة باعتبار حال الناس فيه و انقسامهم إلى طائفة ناضرة الوجوه مبتهجين و اُخرى باسرة الوجوه عابسين آيسين من النجاة، و الإشارة إلى أنّ هذا
المساق تبتدئ من حين نزول الموت ثمّ الإشارة إلى أنّ الإنسان لا يترك سدىً فالّذي خلقه أوّلاً قادر على أن يحييه ثانياً و به تختتم السورة.
قوله تعالى: ( لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ - إلى قوله -ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ ) الّذي يعطيه سياق الآيات الأربع بما يحفّها من الآيات المتقدّمة و المتأخّرة الواصفة ليوم القيامة أنّها معترضة متضمّن أدباً إلهيّاً كلّف النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم أن يتأدّب به حينما يتلقّى ما يوحى إليه من القرآن الكريم فلا يبادر إلى قراءة ما لم يقرأ بعد و لا يحرّك به لسانه و ينصت حتّى يتمّ الوحي.
فالآيات الأربع في معنى قوله تعالى:( وَ لا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ) طه: 114.
فالكلام في هذه الآيات يجري مجرى قول المتكلّم منّا أثناء حديثه لمخاطبه إذا بادر إلى تتميم بعض كلام المتكلّم باللفظة و اللفظتين قبل أن يلفظ بها المتكلم و ذلك يشغله عن التجرّد للإنصات فيقطع المتكلّم حديثه و يعترض و يقول لا تعجل بكلامي و أنصت لتفقه ما أقول لك ثمّ يمضي في حديثه.
فقوله:( لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ) الخطاب فيه للنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم ، و الضميران للقرآن الّذي يوحى إليه أو للوحي، و المعنى لا تحرّك بالوحي لسانك لتأخذه عاجلاً فتسبقنا إلى قراءة ما لم نقرأ بعد فهو كما مرّ في معنى قوله:( وَ لا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ) طه: 114.
و قوله:( إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ ) القرآن ههنا مصدر كالفرقان و الرجحان، و الضميران للوحي، و المعنى لا تعجل به إذ علينا أن نجمع ما نوحيه إليك بضمّ بعض أجزائه إلى بعض و قراءته عليك فلا يفوتنا شيء منه حتّى يحتاج إلى أن تسبقنا إلى قراءة ما لم نوحه بعد.
و قيل: المعنى إنّ علينا أن نجمعه في صدرك بحيث لا يذهب عليك شيء من معانيه و أن نثبت قراءته في لسانك بحيث تقرأه متى شئت و لا يخلو من بعد.
و قوله:( فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ) أي فإذا أتممنا قراءته عليك وحياً فاتّبع
قراءتنا له و اقرأ بعد تمامها.
و قيل: المراد باتّباع قرآنه اتّباعه ذهناً بالإنصات و التوجّه التامّ إليه و هو معنى لا بأس به.
و قيل: المراد فاتّبع في الأوامر و النواهي قرآنه، و قيل: المراد اتّباع قراءته بالتكرار حتّى يرسخ في الذهن و هما معنيان بعيدان.
و قوله:( ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ ) أي علينا إيضاحه عليك بعد ما كان علينا جمعه و قرآنه فثمّ للتأخير الرتبيّ لأنّ البيان مترتّب على الجمع و القراءة رتبة.
و قيل، المعنى ثمّ إنّ علينا بيانه للناس بلسانك نحفظه في ذهنك عن التغيّر و الزوال حتّى تقرأه على الناس.
و قال بعضهم في معنى هذه الآيات إنّ النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم كان يحرّك لسانه عند الوحي بما اُلقي إليه من القرآن مخافة أن ينساه فنهي عن ذلك بالآيات و اُمر بالإنصات حتّى يتمّ الوحي فضمير( لا تُحَرِّكْ بِهِ ) للقرآن أو الوحي باعتبار ما قرأ عليه منه لا باعتبار ما لم يقرأ بعد.
و فيه أنّه لا يلائم سياق الآيات، تلك الملاءمة نظراً إلى ما فيها من النهي عن العجل و الأمر باتّباع قرآنه تعالى بعد ما قرأ، و كذا قوله،( إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ ) فذلك كلّه أظهر فيما تقدّم منها في هذا المعنى.
و عن بعضهم في معنى هذه الآيات، الّذي اختاره أنّه لم يرد القرآن، و إنّما أراد قراءة العباد لكتبهم يوم القيامة يدلّ على ذلك ما قبله و ما بعده، و ليس فيه شيء يدلّ على أنّه القرآن و لا شيء من أحكام الدنيا.
و في ذلك تقريع و توبيخ له حين لا تنفعه العجلة يقول: لا تحرّك لسانك بما تقرأه من صحيفتك الّتي فيها أعمالك يعني اقرأ كتابك و لا تعجل فإنّ هذا الّذي هو على نفسه بصيرة إذا رأى سيّئاته ضجر و استعجل فيقال له توبيخاً: لا تعجل و تثبّت لتعلم الحجّة عليك فإنّا نجمعها لك فإذا جمعناه فاتّبع ما جمع عليك بالانقياد
لحكمه و الاستسلام للتبعة فيه فإنّه لا يمكنك إنكاره ثمّ إنّ علينا بيانه لو أنكرت. انتهى.
و يدفعه أنّ المعترضة لا تحتاج في تمام معناها إلى دلالة ممّا قبلها و ما بعدها عليه على أنّ مشاكلة قوله:( وَ لا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ) في سياقه لهذه الآيات تؤيّد مشاكلتها له في المعنى.
و عن بعضهم أنّ الآيات الأربع متّصلة بما تقدّم من حديث يوم القيامة، و خطاب( لا تُحَرِّكْ ) للنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم ، و ضمير( بِهِ ) ليوم القيامة، و المعنى لا تتفوّه بالسؤال عن وقت القيامة أصلاً و لو كنت غير مكذّب و لا مستهزئ( لِتَعْجَلَ بِهِ ) أي بالعلم به( إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ ) أي من الواجب في الحكمة أن نجمع من نجمعه فيه و نوحي شرح وصفه إليك في القرآن( فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ) أي إذا قرأنا ما يتعلّق به فاتّبع ذلك بالعمل بما يقتضيه من الاستعداد له( ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ ) أي إظهار ذلك بالنفخ في الصور انتهى ملخّصاً و هو كما ترى.
و قد تقدّم في تفسير قوله:( وَ لا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ ) إنّ هذا النهي عن العجل بالقرآن يؤيّد ما ورد في الروايات أنّ للقرآن نزولاً على النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم دفعة غير نزوله تدريجاً.
قوله تعالى: ( كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ وَ تَذَرُونَ الْآخِرَةَ ) خطاب للناس و ليس من تعميم الخطاب السابق في شيء لأنّ خطاب( لا تُحَرِّكْ ) اعتراضيّ غير مرتبط بشيء من طرفيه.
و قوله:( كَلَّا ) ردع عن قوله السابق:( يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ ) و قوله:( بَلْ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ ) - أي الحياة العاجلة و هي الحياة الدنيا -( وَ تَذَرُونَ الْآخِرَةَ ) أي تتركون الحياة الآخرة، و ما في الكلام من الإضراب إضراب عن حسبان عدم الإحياء بعد الموت نظير الإضراب في قوله:( بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسانُ لِيَفْجُرَ أَمامَهُ ) .
قوله تعالى: ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ ) وصف ليوم القيامة بانقسام الوجوه فيه إلى قسمين: ناضرة و باسرة، و نضرة الوجه و اللون و الشجر و نحوها و نضارتها
حسنها و بهجتها.
و المعنى: نظراً إلى ما يقابله من قوله:( وَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ ) إلخ وجوه يوم إذ تقوم القيامة حسنة متهلّلة ظاهرة المسرّة و البشاشة قال تعالى:( تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ) المطفّفين: 24، و قال:( وَ لَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَ سُرُوراً ) الدهر: 11.
و قوله:( إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ ) خبر بعد خبر لوجوه، و( إِلى رَبِّها ) متعلّق بناظرة قدّم عليها لإفادة الحصر أو الأهمّيّة.
و المراد بالنظر إليه تعالى ليس هو النظر الحسّيّ المتعلّق بالعين الجسمانيّة المادّيّة الّتي قامت البراهين القاطعة على استحالته في حقّه تعالى بل المراد النظر القلبيّ و رؤية القلب بحقيقة الإيمان على ما يسوق إليه البرهان و يدلّ عليه الأخبار المأثورة عن أهل العصمةعليهمالسلام و قد أوردنا شطراً منها في ذيل تفسير قوله تعالى:( قالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ ) الأعراف: 143، و قوله تعالى:( ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى ) النجم: 11.
فهؤلاء قلوبهم متوجّهة إلى ربّهم لا يشغلهم عنه سبحانه شاغل من الأسباب لتقطّع الأسباب يومئذ، و لا يقفون موقفاً من مواقف اليوم و لا يقطعون مرحلة من مراحله إلّا و الرحمة الإلهيّة شاملة لهم( وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ) النمل: 89 و لا يشهدون مشهداً من مشاهد الجنّة و لا يتنعّمون بشيء من نعيمها إلّا و هم يشاهدون ربّهم به لأنّهم لا ينظرون إلى شيء و لا يرون شيئاً إلّا من حيث إنّه آية لله سبحانه و النظر إلى الآية من حيث إنّها آية و رؤيتها نظر إلى ذي الآية و رؤية له.
و من هنا يظهر الجواب عمّا اُورد على القول بأنّ تقديم( إِلى رَبِّها ) على( ناظِرَةٌ ) يفيد الحصر و الاختصاص، أنّ من الضروريّ أنّهم ينظرون إلى غيره تعالى كنعم الجنّة.
و الجواب أنّهم لمّا لم يحجبوا عن ربّهم كان نظرهم إلى كلّ ما ينظرون إليه إنّما هو بما أنّه آية، و الآية بما أنّها آية لا تحجب ذا الآية و لا تحول بينه و بين
الناظر إليه فالنظر إلى الآية نظر إلى ذي الآية فهؤلاء لا ينظرون في الحقيقة إلّا إلى ربّهم.
و أمّا ما اُجيب به عنه أنّ تقديم( إِلى رَبِّها ) لرعاية الفواصل و لو سلّم أنّه للاختصاص فالنظر إلى غيره في جنب النظر إليه لا يعدّ نظراً، و لو سلّم فالنظر إليه تعالى في بعض الأحوال لا في جميعها.
فلا يخلو من تكلّف التقييد من غير مقيّد على أنّه أسند النظر إلى الوجوه لا إلى العيون أو الأبصار و وجوه أهل الجنّة إلى ربّهم دائماً من غير أن يواجهوا بها غيره.
قوله تعالى: ( وَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ ) فسّر البسور بشدّة العبوس و الظنّ بالعلم و( فاقِرَةٌ ) صفة محذوفة الموصوف أي فعله فاقرة، و الفاقرة من فقره إذا أصاب فقار ظهره، و قيل: من فقرت البعير إذا وسمت أنفه بالنار.
و المعنى: و وجوه يومئذ شديدة العبوس تعلم أنّه يفعل بها فعلة تقصم ظهورها أو تسم اُنوفها بالنار، و احتمل أن يكون تظنّ خطاباً للنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم بما أنّه سامع و الظنّ بمعناه المعروف.
قوله تعالى: ( كَلَّا إِذا بَلَغَتِ التَّراقِيَ ) ردع عن حبّهم العاجلة و إيثارها على الآخرة كأنّه قيل: ارتدعوا عن ذلك فليس يدوم عليكم و سينزل عليكم الموت فتساقون إلى ربّكم و فاعل( بَلَغَتِ ) محذوف يدلّ عليه السياق كما في قوله تعالى:( فَلَوْ لا إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ) الواقعة: 83 و التقدير إذا بلغت النفس التراقي.
و التراقي العظام المكتنفة للنحر عن يمين و شمال جمع ترقوة، و المعنى ظاهر.
قوله تعالى: ( وَ قِيلَ مَنْ راقٍ ) اسم فاعل من الرقى أي قال من حضره من أهله و أصدقائه من يرقيه و يشفيه؟ كلمة يأس، و قيل: المعنى قال بعض الملائكة لبعض: من يرقى بروحه من الملائكة أ ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب.؟
قوله تعالى: ( وَ ظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ ) أي و علم الإنسان المحتضر من مشاهدة هذه
الأحوال أنّه مفارقته للعاجلة الّتي كان يحبّها و يؤثرها على الآخرة.
قوله تعالى: ( وَ الْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) ظاهره أنّ المراد به التفاف ساق المحتضر بساقه ببطلان الحياة السارية في أطراف البدن عند بلوغ الروح التراقي.
و قيل: المراد به التفاف شدّة أمر الآخرة بأمر الدنيا، و قيل: التفاف حال الموت بحال الحياة، و قيل: التفاف ساق الدنيا و هي شدّة كرب الموت بساق الآخرة و هي شدّة هول المطّلع.
و لا دليل من جهة اللفظ على شيء من هذه المعاني نعم من الممكن أن يقال: إنّ المراد بالتفاف الساق بالساق غشيان الشدائد و تعاقبها عليه واحدة بعد اُخرى من حينه ذلك إلى يوم القيامة فينطبق على كلّ من المعاني.
قوله تعالى: ( إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَساقُ ) المساق مصدر ميميّ بمعنى السوق، و المراد بكون السوق يومئذ إليه تعالى أنّه الرجوع إليه، و عبّر بالمساق للإشارة إلى أن لا خيرة للإنسان في هذا المسير و لا مناص له عنه فهو مسوق مسيّر من يوم موته و هو قوله:( إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَساقُ ) حتّى يرد على ربّه يوم القيامة و هو قوله:( إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ) و لو كان تقديم( إِلى رَبِّكَ ) لإفادة الحصر أفاد انحصار الغاية في الرجوع إليه تعالى.
و قيل: الكلام على تقدير مضاف و تقديم( إِلى رَبِّكَ ) لإفادة الحصر و التقدير إلى حكم ربّك يومئذ المساق أي يساق ليحكم الله و يقضي فيه بحكمه، أو التقدير إلى موعد ربّك و هو الجنّة و النار، و قيل: المراد برجوع المساق إليه تعالى أنّه تعالى هو السائق لا غير، و الوجه ما تقدّم.
قوله تعالى: ( فَلا صَدَّقَ وَ لا صَلَّى وَ لكِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى ) الضمائر راجعة إلى الإنسان المذكور في قوله:( أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ ) إلخ، و المراد بالتصديق المنفيّ تصديق الدعوة الحقّة الّتي يتضمّنها القرآن الكريم، و بالتصلية المنفيّة التوجّه العباديّ إليه تعالى بالصلاة الّتي هي عمود الدين.
و التمطّي - على ما في المجمع - تمدّد البدن من الكسل و أصله أن يلوي
مطاه أي ظهره، و المراد بتمطّيه في ذهابه التبختر و الاختيال استعارة.
و المعنى: فلم يصدّق هذا الإنسان الدعوة فيما فيها من الاعتقاد و لم يصلّ لربّه أي لم يتّبعها فيما فيها من الفروع و ركنها الصلاة و لكن كذّب بها و تولّى عنها ثمّ ذهب إلى أهله يتبختر و يختال مستكبراً.
قوله تعالى: ( أَوْلى لَكَ فَأَوْلى ثُمَّ أَوْلى لَكَ فَأَوْلى ) لا ريب أنّه كلمة تهديد كرّرت لتأكيد التهديد، و لا يبعد - و الله أعلم - أن يكون قوله:( أَوْلى لَكَ ) خبراً لمبتدإ محذوف هو ضمير عائد إلى ما ذكر من حال هذا الإنسان و هو أنّه لم يصدّق و لم يصلّ و لكن كذّب و تولّى ثمّ ذهب إلى أهله متبختراً مختالاً، و إثبات ما هو فيه من الحال له كناية عن إثبات ما هو لازمه من التبعة و العقاب.
فيكون الكلام و هي كلمة ملقاة من الله تعالى إلى هذا الإنسان كلمة طبع طبع الله بها على قلبه حرم بها الإيمان و التقوى و كتب عليه أنّه من أصحاب النار، و الآيتان تشبهان بوجه قوله تعالى:( فَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَ ذُكِرَ فِيهَا الْقِتالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلى لَهُمْ ) سورة محمّد: 20.
و المعنى: ما أنت عليه من الحال أولى و أرجح لك فأولى ثمّ أولى لك فأولى لتذوق وبال أمرك و يأخذك ما اُعدّ لك من العذاب.
و قيل: أولى لك اسم فعل مبنيّ و معناه وليك شرّ بعد شرّ.
و قيل: أولى فعل ماض دعائيّ من الولي بمعنى القرب و فاعل الفعل ضمير مستتر عائد إلى الهلاك و اللّام مزيدة و المعنى أولاك الهلاك.
و قيل: الفاعل ضمير مستتر راجع إليه تعالى و اللّام مزيدة، و المعنى أولاك الله ما تكرهه، أو غير مزيدة و المعنى أدناك الله ممّا تكرهه.
و قيل: معناه الذمّ أولى لك من تركه إلّا أنّه حذف و كثر في الكلام حتّى صار بمنزلة الويل لك و صار من المحذوف الّذي لا يجوز إظهاره.
و قيل: المعنى أهلكك الله هلاكاً أقرب لك من كلّ شرّ و هلاك.
و قيل: أولى أفعل تفضيل بمعنى الأحرى، و خبر لمبتدإ محذوف يقدّر كما يليق بمقامه فالتقدير هنا النار أولى لك أي أنت أحقّ بها و أهل لها فأولى.
و هي وجوه ضعيفة لا تخلو من تكلّف و الوجه الأخير قريب ممّا قدّمنا و ليس به.
قوله تعالى: ( أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً ) مختتم فيه رجوع إلى ما في مفتتح السورة من قوله:( أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ ) .
و الاستفهام للتوبيخ، و السدي المهمل، و المعنى أ يظنّ الإنسان أن يترك مهملاً لا يعتنى به فلا يبعث بإحيائه بعد الموت و لازمه أن لا يكلّف و لا يجزى.
قوله تعالى: ( أَ لَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنى ) اسم كان ضمير راجع إلى الإنسان، و إمناء المنيّ صبّه في الرحم.
قوله تعالى: ( ثُمَّ كانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ) أي ثمّ كان الإنسان - أو المنيّ - قطعة من دم منعقد فقدّره فصوّره بالتعديل و التكميل.
قوله تعالى: ( فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى ) أي فجعل من الإنسان الصنفين: الذكر و الاُنثى.
قوله تعالى: ( أَ لَيْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى ) احتجاج على البعث الّذي ينكرونه استبعاداً له بعموم القدرة و ثبوتها على الخلق الابتدائيّ و الإعادة لا تزيد على الابتداء مئونة بل هي أهون، و قد تقدّم الكلام في تقريب هذه الحجّة في تفسير الآيات المتعرّضة لها مراراً.
( بحث روائي)
في الدرّ المنثور، أخرج الطيالسيّ و أحمد و عبد بن حميد و البخاريّ و مسلم و الترمذي و النسائيّ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن الأنباريّ في المصاحف و الطبرانيّ و ابن مردويه و أبو نعيم و البيهقيّ معاً في الدلائل عن ابن عبّاس قال: كان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم يعالج من التنزيل شدّة، و كان يحرّك به لسانه و شفتيه مخافة أن ينفلت منه يريد أن يحفظه فأنزل الله( لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ ) قال: إنّ علينا أن نجمعه في صدرك ثمّ نقرأه( فَإِذا قَرَأْناهُ ) يقول: إذا أنزلناه عليك( فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ) فاستمع له و أنصت( ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ ) بيّنه( نبيّنه ظ) بلسانك، و في لفظ علينا أن نقرأه فكان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل أطرق - و في لفظ استمع - فإذا ذهب قرأ كما وعده الله.
و فيه، أخرج ابن المنذر و ابن مردويه عن ابن عبّاس قال: كان النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم إذا اُنزل عليه القرآن تعجّل بقراءته ليحفظه فنزلت هذه الآية( لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ ) .
و كان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم لا يعلم ختم سورة حتّى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم.
أقول: و روي ما في معنى صدر الحديث في المجمع، عن ابن جبير و في معناه غير واحد من الروايات، و قد تقدّم أنّ في انطباق هذا المعنى على الآيات خفاء.
و في تفسير القمّيّ قوله تعالى:( كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ ) قال: الدنيا الحاضرة( وَ تَذَرُونَ الْآخِرَةَ ) قال: تدعون( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ ) أي مشرقة( إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ ) قال: ينظرون إلى وجه الله أي رحمة الله و نعمته.
و في العيون، في باب ما جاء عن الرضاعليهالسلام من أخبار التوحيد بإسناده إلى إبراهيم بن أبي محمود قال: قال عليّ بن موسى الرضاعليهالسلام : في قوله تعالى:( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ
ناضِرَةٌ إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ ) يعني مشرقة تنتظر ثواب ربّها.
أقول: و رواه في التوحيد، و الاحتجاج، و المجمع، عن عليّعليهالسلام ، و قد اعترض على أخذ ناظرة بمعنى منتظرة بأنّ الانتظار لا يتعدّى بإلى بل هو متعدّ بنفسه، و ردّ عليه في مجمع البيان بالاستشهاد بقول جميل بن معمر:
و إذا نظرت إليك من ملك |
و البحر دونك جدتني نعما |
و قول الآخر:
إنّي إليك لما وعدت لناظر |
نظر الفقير إلى الغني الموسر |
و عدّ في الكشّاف إطلاق النظر في الآية بمعنى الانتظار استعمالاً كنائيّاً و هو معنى حسن.
و في الدرّ المنثور، أخرج ابن أبي شيبة و عبد بن حميد و الترمذي و ابن جرير و ابن المنذر و الآجريّ في الشريعة و الدارقطنيّ في الرؤية و الحاكم و ابن مردويه و اللالكائيّ في السنّة و البيهقيّ عن ابن عمر قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّ أدنى أهل الجنّة منزلاً لمن ينظر إلى جنانه و أزواجه و نعيمه و خدمه و سرره مسيرة ألف سنة و أكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة و عشيّة.
ثمّ قرأ رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم :( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ ) قال: البياض و الصفاء( إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ ) قال: ينظر كلّ يوم في وجهه.
أقول: الرواية تقبل الانطباق على المعنى الّذي أوردناه في تفسير الآية، و مع الغضّ عنه تقبل الحمل على رحمته و فضله و كرمه تعالى و سائر صفاته الفعليّة فإنّ وجه الشيء ما يستقبل به الشيء غيره و ما يستقبل به الله سبحانه خلقه هو صفاته الكريمة فالنظر إلى رحمة الله و فضله و كرمه و صفاته الكريمة نظر إلى وجه الله الكريم.
و فيه، أخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : في قول الله:( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ ) قال: ينظرون إلى ربّهم بلا كيفيّة و لا حدّ محدود و لا صفة معلومة.
أقول: و الرواية تؤيّد ما قدّمنا في تفسير الآية أنّ المراد به النظر القلبيّ
و رؤية القلب دون العين الحسّيّة، و هي تفسّر ما ورد في عدّة روايات من طرق أهل السنّة ممّا ظاهره التشبيه و أنّ الرؤية بالعين الحسّيّة الّتي لا تفارق المحدوديّة.
و في تفسير القمّيّ في قوله تعالى:( كَلَّا إِذا بَلَغَتِ التَّراقِيَ ) قال: يعني النفس إذا بلغت الترقوة( وَ قِيلَ مَنْ راقٍ ) قال: يقال له: من يرقيك( وَ ظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ ) علم أنّه الفراق.
و في الكافي، بإسناده إلى جابر عن أبي جعفرعليهالسلام قال: سألته عن قول الله عزّوجلّ:( وَ قِيلَ مَنْ راقٍ وَ ظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ ) قال: فإنّ ذلك ابن آدم إذا حلّ به الموت قال: هل من طبيب( وَ ظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ ) أيقن بمفارقة الأحبّة( وَ الْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) قال: التفت الدنيا بالآخرة( إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَساقُ ) قال: المسير إلى ربّ العالمين.
و في تفسير القمّيّ:( وَ الْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) قال: التفّت الدنيا بالآخرة( إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَساقُ ) قال: يساقون إلى الله.
و في العيون، بإسناده عن عبدالعظيم الحسنيّ قال، سألت محمّد بن عليّ الرضاعليهالسلام عن قول الله عزّوجلّ:( أَوْلى لَكَ فَأَوْلى ثُمَّ أَوْلى لَكَ فَأَوْلى ) قال: يقول الله عزّوجلّ بعداً لك من خير الدنيا و بعداً لك من خير الآخرة.
أقول: يمكن إرجاعه إلى ما قدّمناه من معنى الآيتين، و كذا إلى بعض ما قيل فيه.
و في المجمع، و جاءت الرواية: أنّ رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم أخذ بيد أبي جهل ثمّ قال له: أولى لك فأولى ثمّ أولى لك فأولى. فقال أبوجهل: بأيّ شيء تهدّدني لا تستطيع أنت و ربّك أن تفعلاً بي شيئاً، و إنّي لأعزّ أهل هذا الوادي، فأنزل الله سبحانه كما قال له رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم .
أقول: و روي ما في معناه في الدرّ المنثور، عن عدّة عن قتادة قال: ذكر لنا و ساق الحديث.
و في تفسير القمّيّ في قوله تعالى:( أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً ) قال:
لا يحاسب و لا يعذّب و لا يسأل عن شيء.
و في العلل، بإسناده إلى مسعدة بن زياد قال: قال رجل لجعفر بن محمّدعليهالسلام ، يا أباعبدالله إنّا خلقنا للعجب قال: و ما ذلك لله أنت؟ قال: خلقنا للفناء فقال يا ابن أخ خلقنا للبقاء، و كيف يفنى جنّة لا تبيد و نار لا تخمد؟ و لكن قل: إنّما نتحوّل من دار إلى دار.
و في المجمع، و جاء في الحديث عن البراء عن عازب قال: لمّا نزلت هذه الآية( أَ لَيْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى ) قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : سبحانك اللّهمّ و بلى: و روي ذلك عن أبي جعفر و أبي عبداللهعليهمالسلام .
أقول: و روي في الدرّ المنثور، عن أبي هريرة و غيره: أنّهصلىاللهعليهوآلهوسلم إذا قرأ الآية قال: سبحانك اللّهمّ و بلى، و كذا في العيون، عن الرضاعليهالسلام : أنّه كان إذا قرأ السورة قال عند الفراغ سبحانك اللّهمّ بلى.
( سورة الدهر مدنيّة و هي إحدى و ثلاثون آية)
( سورة الإنسان الآيات 1 - 22)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ( 1 ) إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ( 2 ) إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ( 3 ) إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ( 4 ) إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ( 5 ) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ( 6 ) يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ( 7 ) وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ( 8 ) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ( 9 ) إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ( 10 ) فَوَقَاهُمُ اللهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ( 11 ) وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ( 12 ) مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ( 13 ) وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ( 14 ) وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا ( 15 ) قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ( 16 ) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ( 17 ) عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ( 18 ) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ( 19 ) وَإِذَا
رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ( 20 ) عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ( 21 ) إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ( 22 )
( بيان)
تذكر السورة خلق الإنسان بعد ما لم يكن شيئاً مذكوراً ثمّ هدايته السبيل إمّا شاكراً و إمّا كفوراً و أنّ الله اعتد للكافرين أنواع العذاب و للأبرار ألوان النعم - و قد فصّل القول في وصف نعيمهم في ثمان عشرة آية و هو الدليل على أنّه المقصود بالبيان -.
ثمّ تذكر مخاطباً للنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم أنّ القرآن تنزيل منه تعالى عليه و تذكرة فليصبر لحكم ربّه و لا يتّبع الناس في أهوائهم و ليذكر اسم ربّه بكرة و عشيّاً و ليسجد له من الليل و ليسبّحه ليلاً طويلاً.
و السورة مدنيّة بتمامها أو صدرها - و هي اثنتان و عشرون آية من أوّلها - مدنيّ، و ذيلها - و هي تسع آيات من آخرها - مكّيّ و قد أطبقت روايات أهل البيتعليهمالسلام على كونها مدنيّة، و استفاضت بذلك روايات أهل السنّة.
و قيل بكونها مكّيّة بتمامها، و سيوافيك تفصيل القول في ذلك في البحث الروائيّ التالي إن شاء الله تعالى.
قوله تعالى: ( هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً ) الاستفهام للتقرير فيفيد ثبوت معنى الجملة و تحقّقه أي قد أتى على الإنسان إلخ و لعلّ هذا مراد من قال من قدماء المفسّرين: إنّ( هَلْ ) في الآية بمعنى قد، لا على أنّ ذلك أحد معاني( هل ) كما ذكره بعضهم.
و المراد بالإنسان الجنس: و أمّا قول بعضهم: إنّ المراد به آدمعليهالسلام فلا
يلائمه قوله في الآية التالية:( إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ ) .
و الحين قطعة من الزمان محدودة قصيرة كانت أو طويلة، و الدهر الزمان الممتدّ من دون تحديد ببداية أو نهاية.
و قوله:( شَيْئاً مَذْكُوراً ) أي شيئاً يذكر باسمه في المذكورات أي كان يذكر مثلاً الأرض و السماء و البرّ و البحر و غير ذلك و لا يذكر الإنسان لأنّه لم يوجد بعد حتّى وجد فقيل: الإنسان فكونه مذكوراً كناية عن كونه موجوداً بالفعل فالنفي في قوله:( لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً ) متوجّه إلى كونه شيئاً مذكوراً لا إلى أصل كونه شيئاً فقد كان شيئاً و لم يكن شيئاً مذكوراً و يؤيّده قوله:( إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ ) إلخ فقد كان موجوداً بمادّته و لم يتكوّن بعد إنساناً بالفعل و الآية و ما يتلوها من الآيات واقعة في سياق الاحتجاج يبيّن بها أنّ الإنسان حادث يحتاج في وجوده إلى صانع يصنعه و خالق يخلقه، و قد خلقه ربّه و جهّزه التدبير الربوبيّ بأدوات الشعور من السمع و البصر يهتدي بها إلى السبيل الحقّ الّذي من الواجب أن يسلكه مدى حياته فإن كفر فمصيره إلى عذاب أليم و إن شكر فإلى نعيم مقيم.
و المعنى هل أتى - قد أتى - على الإنسان قطعة محدودة من هذا الزمان الممتدّ غير المحدود و الحال أنّه لم يكن موجوداً بالفعل مذكوراً في عداد المذكورات.
قوله تعالى: ( إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْناهُ سَمِيعاً بَصِيراً ) النطفة في الأصل بمعنى الماء القليل غلب استعماله في ماء الذكور من الحيوان الّذي يتكوّن منه مثله، و أمشاج جمع مشيج أو المشج بفتحتين أو بفتح فكسر بمعنى المختلط الممتزج، و وصفت بها النطفة باعتبار أجزائها المختلفة أو اختلاط ماء الذكور و الإناث.
و الابتلاء نقل الشيء من حال إلى حال و من طور إلى طور كابتلاء الذهب في البوتقة، و ابتلاؤه تعالى الإنسان في خلقه من النطفة هو ما ذكره في مواضع من كلامه أنّه يخلق النطفة فيجعلها علقة و العلقة مضغة إلى آخر الأطوار الّتي تتعاقبها حتّى ينشئه خلقاً آخر.
و قيل: المراد بابتلائه امتحانه بالتكليف، و يدفعه تفريع قوله:( فَجَعَلْناهُ سَمِيعاً بَصِيراً ) على الابتلاء و لو كان المراد به التكليف كان من الواجب تفريعه على جعله سميعاً بصيراً لا بالعكس، و الجواب عنه بأنّ في الكلام تقديماً و تأخيراً و التقدير إنّا خلقناه من نطفة أمشاج فجعلناه سميعاً بصيراً لنبتليه، لا يصغي إليه.
و قوله:( فَجَعَلْناهُ سَمِيعاً بَصِيراً ) سياق الآيات و خاصّة قوله:( إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ ) إلخ يفيد أنّ ذكر جعله سميعاً بصيراً للتوسّل به في التدبير الربوبيّ إلى غايته و هي أن يرى آيات الله الدالّة على المبدإ و المعاد و يسمع كلمة الحقّ الّتي تأتيه من جانب ربّه بإرسال الرسل و إنزال الكتب فيدعوه البصر و السمع إلى سلوك سبيل الحقّ و السير في مسير الحياة بالإيمان و العمل الصالح فإن لزم السبيل الّذي هدي إليه أداه إلى نعيم الأبد و إلّا فإلى عذاب مخلّد.
و ذكر الإنسان في الآية من وضع الظاهر موضع الضمير و النكتة فيه تسجيل أنّه تعالى هو خالقه و مدبّر أمره.
و المعنى: إنّا خلقنا الإنسان من نطفة هي أجزاء مختلطة ممتزجة و الحال أنّا ننقله من حال إلى حال و من طور إلى طور فجعلناه سميعاً بصيراً ليسمع ما يأتيه من الدعوة الإلهيّة، و يبصر الآيات الإلهيّة الدالّة على وحدانيّته تعالى و النبوّة و المعاد.
قوله تعالى: ( إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً ) الهداية بمعنى إراءة الطريق دون الإيصال إلى المطلوب و المراد بالسبيل السبيل بحقيقة معنى الكلمة و هو المؤدّي إلى الغاية المطلوبة و هو سبيل الحقّ.
و الشكر استعمال النعمة بإظهار كونها من منعمها و قد تقدّم في تفسير قوله تعالى:( وَ سَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ ) آل عمران: 144 أنّ حقيقة كون العبد شاكراً لله كونه مخلصاً لربّه، و الكفران استعمالها مع ستر كونها من المنعم.
و قوله:( إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً ) حالان من ضمير( هَدَيْناهُ ) لا من( السَّبِيلَ ) كما قاله بعضهم، و( إِمَّا ) يفيد التقسيم و التنويع أي إنّا هديناه السبيل حال كونه
منقسماً إلى الشاكر و الكفور أي إنّه مهديّ سواء كان كذا أو كذلك.
و التعبير بقوله:( إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً ) هو الدليل أوّلاً: على أنّ المراد بالسبيل السنّة و الطريقة الّتي يجب على الإنسان أن يسلكها في حياته الدنيا لتوصله إلى سعادته في الدنيا و الآخرة و تسوقه إلى كرامة القرب و الزلفى من ربّه و محصّله الدين الحقّ و هو عندالله الإسلام.
و به يظهر أنّ تفسير بعضهم السبيل بسبيل الخروج من الرحم غير سديد.
و ثانياً: أنّ السبيل المهديّ إليه سبيل اختياريّ و أنّ الشكر و الكفر اللّذين يترتّبان على الهداية المذكورة واقعان في مستقرّ الاختيار للإنسان أن يتلبّس بأيّهما شاء من غير إكراه و إجبار كما قال تعالى:( ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ) عبس: 20، و ما في آخر السورة من قوله تعالى:( فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلًا وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ ) إنّما يفيد تعلّق مشيّته تعالى بمشيّة العبد لا بفعل العبد الّذي تعلّقت به مشيّة العبد حتّى يفيد نفي تأثير مشيّة العبد المتعلّقة بفعله، و قد تقدّمت الإشارة إلى هذا المعنى في هذا الكتاب مراراً.
و الهداية الّتي هي نوع إيذان و إعلام منه تعالى للإنسان هداية فطريّة هي تنبيه بسبب نوع خلقته و ما جهّز به وجوده بإلهام من الله سبحانه على حقّ الاعتقاد و صالح العمل قال تعالى:( وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها ) الشمس: 8 و أوسع مدلولاً منه قوله تعالى:( فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ) الروم: 30.
و هداية قوليّة من طريق الدعوة يبعث الأنبياء و إرسال الرسل و إنزال الكتب و تشريع الشرائع الإلهيّة، و لم يزل التدبير الربوبيّ تدعم الحياة الإنسانيّة بالدعوة الدينيّة القائم بها أنبياؤه و رسله، و يؤيّد بذلك دعوة الفطرة كما قال:( إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلى نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ - إلى أن قال -رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ) النساء: 165.
و من الفرق بين الهدايتين أنّ الهداية الفطريّة عامّة بالغة لا يستثني منها إنسان لأنها لازم الخلقة الإنسانيّة و هي في الأفراد بالسويّة غير أنّها ربّما تضعف أو يلغو أثرها لعوامل و أسباب تشغل الإنسان و تصرفه عن التوجّه إلى ما يدعو إليه عقله و يهديه إليه فطرته أو ملكات و أحوال رديئة سيّئة تمنعه عن إجابة نداء الفطرة كالعناد و اللجاج و ما يشبه ذلك قال تعالى:( أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللهُ عَلى عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلى سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلى بَصَرِهِ غِشاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ ) الجاثية: 23، و الهداية المنفيّة في الآية بمعنى الإيصال إلى المطلوب دون إراءة الطريق بدليل قوله:( وَ أَضَلَّهُ اللهُ عَلى عِلْمٍ ) .
و أمّا الهداية القوليّة و هي التي تتضمّنها الدعوة الدينيّة فإنّ من شأنها أن تبلغ المجتمع فتكون في معرض من عقول الجماعة فيرجع إليها من آثر الحقّ على الباطل و أمّا بلوغها لكلّ واحد واحد منهم فإنّ العلل و الأسباب الّتي يتوسّل بها إلى بيان أمثال هذه المقاصد ربّما لا تساعد على ذلك على ما في الظروف و الأزمنة و البيئات من الاختلاف و كيف يمكن لإنسان أن يدعو كلّ إنسان إلى ما يريد بنفسه أو بوسائط من نوعه؟ فمن المتعذّر ذلك جدّاً.
و إلى المعنى الأوّل أشار تعالى بقوله:( وَ إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِيها نَذِيرٌ ) فاطر: 24، و إلى الثاني بقوله:( لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ فَهُمْ غافِلُونَ ) يس: 6.
فمن بلغته الدعوة و انكشف له الحقّ فقد تمّت عليه الحجّة و من لم تبلغه الدعوة بلوغاً ينكشف به له الحقّ فقد أدركه الفضل الإلهيّ بعدّه مستضعفاً أمره إلى الله إن يشأ يغفر له و إن يشأ يعذّبه قال تعالى:( إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ) النساء: 98.
ثمّ من الدليل على أنّ الدعوة الإلهيّة و هي الهداية إلى السبيل حقّ يجب على الإنسان أن يتّبعها فطرة الإنسان و خلقته المجهّزة بما يهدي إليها من الاعتقاد و العمل، و وقوع الدعوة خارجاً من طريق النبوّة و الرسالة فإنّ سعادة كلّ موجود و كماله في الآثار و الأعمال الّتي تناسب ذاته و تلائمها بما جهّزت به من القوى
و الأدوات فسعادة الإنسان و كماله في اتّباع الدين الإلهيّ الّذي هو سنّة الحياة الفطرية و قد حكم به العقل و جاءت به الأنبياء و الرسل عليهم السلام.
قوله تعالى: ( إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ سَلاسِلَ وَ أَغْلالًا وَ سَعِيراً ) الاعتاد التهيئة، و سلاسل جمع سلسلة و هي القيد الّذي يقاد به المجرم، و أغلال جمع غلّ بالضمّ قيل هي القيد الّذي يجمع اليدين على العنق، و قال الراغب: فالغلّ مختصّ بما يقيّد به فيجعل الأعضاء وسطه. انتهى. و السعير النار المشتعلة، و المعنى ظاهر.
و الآية تشير إلى تبعة الإنسان الكفور المذكور في قوله:( إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً ) و قدّم بيان تبعته على بيان جزاء الإنسان الشاكر لاختصار الكلام فيه.
قوله تعالى: ( إِنَّ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كانَ مِزاجُها كافُوراً ) الكأس إناء الشراب إذا كان فيه شراب، و المزاج ما يمزج به كالحزام لما يحزم به، و الكافور معروف يضرب به المثل في البرودة و طيب الرائحة، و قيل: هو اسم عين في الجنّة.
و الأبرار جمع برّ بفتح الباء صفة مشبهة من البرّ و هو الإحسان و يتحصّل معناه في أن يحسن الإنسان في عمله من غير أن يريد به نفعاً يرجع إليه من جزاء أو شكور فهو يريد الخير لأنّه خير لا لأنّ فيه نفعاً يرجع إلى نفسه و إن كرهت نفسه ذلك فيصبر على مرّ مخالفة نفسه فيما يريده و يعمل العمل لأنّه خير في نفسه كالوفاء بالنذر أو لأنّ فيه خيراً لغيره كإطعام الطعام للمستحقّين من عباد الله.
و إذ لا خير في عمل و لا صلاح إلّا بالإيمان بالله و رسوله و اليوم الآخر كما قال تعالى:( أُولئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللهُ أَعْمالَهُمْ ) الأحزاب: 19 إلى غير ذلك من الآيات.
فالأبرار مؤمنون بالله و رسوله و اليوم الآخر، و إذ كان إيمانهم إيمان رشد و بصيرة فهم يرون أنفسهم عبيداً مملوكين لربّهم، له خلقهم و أمرهم، لا يملكون لأنفسهم نفعاً و لا ضرّاً عليهم أن لا يريدوا إلّا ما أراده ربّهم و لا يفعلوا إلّا ما يرتضيه فقدّموا إرادته على إرادة أنفسهم و عملوا له فصبروا على مخالفة أنفسهم فيما تهواه
و تحبّه و كلفة الطاعة، و عملوا ما عملوه لوجه الله، فأخلصوا العبوديّة في مرحلة العمل لله سبحانه.
و هذه الصفات هي الّتي عرّف سبحانه الأبرار بها كما يستفاد من قوله:( يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللهِ ) و قوله:( إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ ) و قوله:( وَ جَزاهُمْ بِما صَبَرُوا ) و هي المستفادة من قوله في صفتهم:( لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ ) الخ البقرة: 177 و قد مرّ بعض الكلام في معنى البرّ في تفسير الآية و سيأتي بعضه في قوله:( كَلَّا إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ) المطفّفين: 18.
و الآية أعني قوله:( إِنَّ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ ) إلخ بما يتبادر من معناها من حيث مقابلتها لقوله:( إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ ) إلخ المبيّن لحال الكافرين في الآخرة، تبيّن حال الأبرار في الآخرة في الجنّة، و أنّهم يشربون من شراب ممزوج بالكافور بارداً طيّب الرائحة.
قوله تعالى:: ( عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللهِ يُفَجِّرُونَها تَفْجِيراً ) ( عَيْناً ) منصوب بنزع الخافض و التقدير من عين أو بالاختصاص و التقدير أخصّ عينا، و الشرب - على ما قيل - يتعدّى بنفسه و بالباء فشرب بها و شربها واحد، و التعبير عنهم بعباد الله للإشارة إلى تحلّيهم بحلية العبوديّة و قيامهم بلوازمها على ما يفيده سياق المدح.
و تفجير العين شقّ الأرض لإجرائها، و ينبغي أن يحمل تفجيرهم العين على إرادتهم جريانها لأنّ نعم الجنّة لا تحتاج في تحقّقها و التنعّم بها إلى أزيد من مشيّة أهلها قال تعالى:( لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها ) ق: 35.
و الآيتان - كما تقدّمت الإشارة إليه - تصفان تنعّم الأبرار بشراب الجنّة في الآخرة، و بذلك فسّرت الآيتان.
و لا يبعد أن تكون الآيتان مسوقتين على مسلك تجسّم الأعمال تصفان حقيقة عملهم الصالح من الإيفاء بالنذر و إطعام الطعام لوجه الله، و أنّ أعمالهم المذكورة بحسب باطنها شرب من كأس مزاجها كافور من عين لا يزالون يفجّرونها بأعمالهم الصالحة
و ستظهر لهم بحقيقتها في جنّة الخلد و إن كانت في الدنيا في صورة الأعمال فتكون الآيتان في مجرى أمثال قوله تعالى:( إِنَّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ أَغْلالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ) يس: 8.
و يؤيّد ذلك ظاهر قوله( يَشْرَبُونَ ) و( يَشْرَبُ بِها ) و لم يقل: سيشربون و سيشرب بها، و وقوع قوله: يشربون و يوفون و يخافون و يطعمون متعاقبة في سياق واحد، و ذكر التفجير في قوله:( يُفَجِّرُونَها تَفْجِيراً ) الظاهر في استخراج العين و إجرائها بالتوسّل بالأسباب.
و لهم في مفردات الآيتين و إعرابها أقاويل كثيرة مختلفة مذكورة في المطولات فليراجعها من أراد الوقوف عليها.
قوله تعالى: ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ يَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً ) المستطير اسم فاعل من استطار إذا فشا و انتشر في الأقطار غاية الانتشار و هو أبلغ من طار كما قيل: يقال: استطار الحريق و استطار الفجر إذا اتّسعا غايته، و المراد باستطارة شرّ اليوم و هو يوم القيامة بلوغ شدائده و أهواله و ما فيه من العذاب غايته.
و المراد بالإيفاء بالنذر ما هو ظاهره المعروف من معناه، و قول القائل: إنّ المراد به ما عقدوا عليه قلوبهم من العمل بالواجبات أو ما عقدوا عليه القلوب من اتّباع الشارع في جميع ما شرّعه خلاف ظاهر اللفظ من غير دليل يدل عليه.
قوله تعالى: ( وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً ) ضمير( عَلى حُبِّهِ ) للطعام على ما هو الظاهر، و المراد بحبّه توقان النفس إليه لشدّة الحاجة، و يؤيّد هذا المعنى قوله تعالى:( لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ) آل عمران: 92.
و قيل: الضمير لله سبحانه أي يطعمون الطعام حبّاً لله لا طمعاً في الثواب، و يدفعه أنّ قوله تعالى حكاية منهم:( إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ ) يغني عنه.
و يليه في الضعف ما قيل: إنّ الضمير للإطعام المفهوم من قوله:( وَ يُطْعِمُونَ )
وجه الضعف أنّه إن اُريد بحب الإطعام حقيقة معناه فليس في حبّ الإطعام في نفسه فضل حتّى يمدحوا به، و إن اُريد به كون الإطعام بطيب النفس و عدم التكلّف فهو خلاف الظاهر، و رجوع الضمير إلى الطعام هو الظاهر.
و المراد بالمسكين و اليتيم معلوم، و المراد بالأسير ما هو الظاهر منه و هو المأخوذ من أهل دار الحرب.
و قول بعضهم: إنّ المراد به اُسارى بدر أو الأسير من أهل القبلة في دار الحرب بأيدي الكفّار أو المحبوس أو المملوك من العبيد أو الزوجة كلّ ذلك تكلّف من غير دليل يدلّ عليه.
و الّذي يجب أن يتنبّه له أنّ سياق هذه الآيات سياق الاقتصاص تذكر قوماً من المؤمنين تسمّيهم الأبرار و تكشف عن بعض أعمالهم و هو الإيفاء بالنذر و إطعام مسكين و يتيم و أسير و تمدحهم و تعدهم الوعد الجميل.
فما تشير إليه من القصّة سبب النزول، و ليس سياقها سياق فرض موضوع و ذكر آثارها الجميلة، ثمّ الوعد الجميل عليها، ثمّ إنّ عدّ الأسير فيمن أطعمه هؤلاء الأبرار نعم الشاهد على كون الآيات مدنيّة فإنّ الأسر إنّما كان بعد هجرة النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم و ظهور الإسلام على الكفر و الشرك لا قبلها.
قوله تعالى: ( إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ لا شُكُوراً ) وجه الشيء هو ما يستقبل به غيره، و وجهه تعالى صفاته الفعليّة الكريمة الّتي يفيض بها الخير على خلقه من الخلق و التدبير و الرزق و بالجملة الرحمة العامّة الّتي بها قيام كلّ شيء، و معنى كون العمل لوجه الله على هذا كون الغاية في العمل هي الاستفاضة من رحمة الله و طلب مرضاته بالاقتصار على ذلك و الإعراض عمّا عند غيره من الجزاء المطلوب، و لذا ذيّلوا قولهم:( إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ ) بقولهم:( لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ لا شُكُوراً ) .
و وراء ذلك صفاته الذاتيّة الكريمة الّتي هي المبدأ لصفاته الفعليّة و لما يترتّب
عليها من الخير في العالم، و مرجع كون العمل لوجه الله على هذا هو الإتيان بالعمل حبّاً لله لأنّه الجميل على الإطلاق، و إن شئت فقل: عبادته تعالى لأنّه أهل للعبادة.
و ابتغاء وجه الله بجعله غاية داعية في الأعمال مذكور في مواضع من كلامه تعالى كقوله:( وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ) الكهف: 28، و قوله:( وَ ما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللهِ ) البقرة: 272، و في هذا المعنى قوله:( وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) البيّنة: 5، و قوله:( فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) المؤمن: 65، و قوله:( أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ ) الزمر: 3.
و قوله:( لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ لا شُكُوراً ) الجزاء مقابلة العمل بما يعادله إن خيراً فخيراً و إن شرّاً فشرّاً، و يعمّ الفعل و القول لكن المراد به في الآية بقرينة مقابلته الشكور مقابلة إطعامهم عملاً لا لساناً.
و الشكر و الشكور ذكر النعمة و إظهارها قلباً أو لساناً أو عملاً، و المراد به في الآية و قد قوبل بالجزاء الثناء الجميل لساناً.
و الآية أعني قوله:( إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ ) إلخ خطاب منهم لمن أطعموه من المسكين و اليتيم و الأسير إمّا بلسان المقال فهي حكاية قولهم أو بتقدير القول و كيف كان فقد أرادوا به تطييب قلوبهم أن يأمنوا المنّ و الأذى، و إمّا بلسان الحال و هو ثناء من الله عليهم لما يعلم من الإخلاص في قلوبهم.
قوله تعالى: ( إِنَّا نَخافُ مِنْ رَبِّنا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً ) عدّ اليوم و هو يوم القيامة عبوساً من الاستعارة، و المراد بعبوسه ظهوره على المجرمين بكمال شدّته، و القمطرير الصعب الشديد على ما قيل.
و الآية في مقام التعليل لقولهم المحكي:( إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ ) إلخ ينبّهون بقولهم هذا أنّ قصرهم العمل في ابتغاء وجه الله تعالى إخلاصاً للعبوديّة لمخافتهم ذاك اليوم
الشديد، و لم يكتفوا بنسبة المخافة إلى اليوم حتّى نسبوه نحواً من النسبة إلى ربّهم فقالوا:( نَخافُ مِنْ رَبِّنا يَوْماً ) إلخ لأنّهم لمّا لم يريدوا إلّا وجه ربّهم فهم لا يخافون غيره كما لا يرجون غيره و إنّما يخافون و يرجون ربّهم فلا يخافون يوم القيامة إلّا لأنّه من ربّهم يحاسب فيه عباده على أعمالهم فيجزيهم بها.
و أمّا قوله قبلاً:( وَ يَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً ) حيث نسب خوفهم إلى اليوم فإنّ الواصف فيه هو الله سبحانه و قد نسب اليوم بشدائده إلى نفسه قبلاً حيث قال:( إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ سَلاسِلَ ) إلخ.
و بالجملة ما ذكروه من الخوف مخافة في مقام العمل لما يحاسب العبد على عمله فالعبوديّة لازمة للإنسان لا تفارقه و إن بلغ ما بلغ قال تعالى:( إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ ) الغاشية: 26.
قوله تعالى: ( فَوَقاهُمُ اللهُ شَرَّ ذلِكَ الْيَوْمِ وَ لَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَ سُرُوراً ) الوقاية الحفظ و المنع من الأذى و لقّي بكذا يلقّيه أي استقبله به و النضرة البهجة و حسن اللون و السرور مقابل المساءة و الحزن.
و المعنى: فحفظهم الله و منع عنهم شرّ ذلك اليوم و استقبلهم بالنضرة و السرور، فهم ناضرة الوجوه مسرورون يومئذ كما قال:( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ ) القيامة: 22.
قوله تعالى: ( وَ جَزاهُمْ بِما صَبَرُوا جَنَّةً وَ حَرِيراً ) المراد بالصبر صبرهم عند المصيبة و على الطاعة و عن المعصية فإنّهم ابتغوا في الدنيا وجه ربّهم و قدّموا إرادته على إرادتهم فصبروا على ما قضى به فيهم و أراده من المحن و مصائب الدنيا في حقّهم، و صبروا على امتثال ما أمرهم به و صبروا على ترك ما نهاهم عنه و إن كان مخالفاً لأهواء أنفسهم فبدّل الله ما لقوه من المشقّة و الكلفة نعمة و راحة.
قوله تعالى: ( مُتَّكِئِينَ فِيها عَلَى الْأَرائِكِ لا يَرَوْنَ فِيها شَمْساً وَ لا زَمْهَرِيراً ) الأرائك جمع أريكة و هو ما يتّكئ عليه، و الزمهرير البرد الشديد، و المعنى حال كونهم
متّكئين في الجنّة على الأرائك لا يرون فيها شمساً حتّى يتأذّوا بحرّها و لا زمهريراً حتّى يتأذّوا ببرده.
قوله تعالى: ( وَ دانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُها وَ ذُلِّلَتْ قُطُوفُها تَذْلِيلًا ) الظلال جمع ظلّ، و دنوّ الظلال عليهم قربها منهم بحيث تنبسط عليهم فكانّ الدنوّ مضمّن معنى الانبساط و قطوف جمع قطف بالكسر فالسكون و هو الثمرة المقطوفة المجتناة، و تذليل القطوف لهم جعلها مسخّرة لهم يقطفونها كيف شاؤا من غير مانع أو كلفة.
قوله تعالى: ( وَ يُطافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ أَكْوابٍ كانَتْ قَوارِيرَا ) الآنية جمع إناء كأكسية جمع كساء و هو الوعاء، و أكواب جمع كوب و هو إناء الشراب الّذي لا عروة له و لا خرطوم و المراد طواف الولدان المخلّدين عليهم بالآنية و أكواب الشراب كما سيأتي في قوله:( وَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ ) الآية.
قوله تعالى: ( قَوارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوها تَقْدِيراً ) بدل من قوارير في الآية السابقة، و كون القوارير من فضّة مبنيّ على التشبيه البليغ أي إنّها في صفاء الفضّة و إن لم تكن منها حقيقة، كذا قيل. و احتمل أن يكون بحذف مضاف و التقدير من صفاء الفضّة.
و ضمير الفاعل في( قَدَّرُوها) للأبرار و المراد بتقديرهم الآنية و الأكواب كونها على ما شاؤا من القدر ترويهم بحيث لا تزيد و لا تنقص كما قال تعالى:( لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها ) ق: 35 و قد قال تعالى قبل:( يُفَجِّرُونَها تَفْجِيراً ) .
و يحتمل رجوع الضمير إلى الطائفين المفهوم من قوله:( يُطافُ عَلَيْهِمْ ) و المراد بتقديرهم الآنية و الأكواب إتيانهم بها على قدر ما أرادوا محتوية على ما اشتهوا قدر ما اشتهوا.
قوله تعالى: ( وَ يُسْقَوْنَ فِيها كَأْساً كانَ مِزاجُها زَنْجَبِيلًا ) قيل: إنّهم كانوا يستطيبون الزنجبيل في الشراب فوعد الأبرار بذلك و زنجبيل الجنّة أطيب و ألذّ.
قوله تعالى: ( عَيْناً فِيها تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ) أي من عين أو التقدير أعني أو أخصّ
عينا.
قال الراغب: و قوله:( سَلْسَبِيلًا ) أي سهلاً لذيذاً سلساً حديد الجرية.
قوله تعالى: ( وَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ إِذا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً مَنْثُوراً ) أي ولدان دائمون على ما هم عليه من الطراوة و البهاء و صباحة المنظر، و قيل: أي مقرّطون بخلدة و هي ضرب من القرط.
و المراد بحسبانهم لؤلؤاً منثوراً أنّهم في صفاء ألوانهم و إشراق وجوههم و انعكاس أشعّة بعضهم على بعض و انبثاثهم في مجالسهم كاللؤلؤ المنثور.
قوله تعالى: ( وَ إِذا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَ مُلْكاً كَبِيراً ) ( ثَمَّ ) ظرف مكان ممحّض في الظرفيّة، و لذا قيل: إنّ معنى( رَأَيْتَ ) الأوّل: رميت ببصرك، و المعنى و إذا رميت ببصرك ثمّ يعني الجنّة رأيت نعيماً لا يوصف و ملكاً كبيراً لا يقدّر قدره.
و قيل:( ثَمَّ ) صلة محذوفة الموصول و التقدير و إذا رأيت ما ثمّ من النعيم و الملك، و هو كقوله:( لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ) الأنعام: 94 و الكوفيّون من النحاة يجوّزون حذف الموصول و إبقاء الصلة و إن منعه البصريّون منهم.
قوله تعالى: ( عالِيَهُمْ ثِيابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَ إِسْتَبْرَقٌ ) إلخ الظاهر أنّ( عالِيَهُمْ ) حال من الأبرار الراجعة إليه الضمائر و( ثِيابُ ) فاعله، و السندس - كما قيل - ما رقّ نسجه من الحرير، و الخضر صفة ثياب و الإستبرق ما غلظ نسجه من ثياب الحرير، و هو معرّب كالسندس.
و قوله:( وَ حُلُّوا أَساوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ) التحلية التزيين، و أساور جمع سوار و هو معروف، و قال الراغب: هو معرّب دستواره.
و قوله:( وَ سَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً ) أي بالغاً في التطهير لا تدع قذارة إلّا أزالها و من القذارة قذارة الغفلة عن الله سبحانه و الاحتجاب عن التوجّه إليه فهم غير محجوبين عن ربّهم و لذا كان لهم أن يحمدوا ربّهم كما قال:( وَ آخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ) يونس: 10 و قد تقدّم في تفسير سورة الحمد أنّ الحمد وصف لا يصلح له إلّا المخلصون من عباد الله تعالى لقوله:( سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ ) الصافّات: 160.
و قد أسقط تعالى في قوله:( وَ سَقاهُمْ رَبُّهُمْ ) الوسائط كلّها و نسب سقيهم إلى نفسه، و هذا أفضل ما ذكره الله تعالى من النعيم الموهوب لهم في الجنّة، و لعلّه من المزيد المذكور في قوله:( لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ ) ق: 35.
قوله تعالى: ( إِنَّ هذا كانَ لَكُمْ جَزاءً وَ كانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً ) حكاية ما يخاطبون به من عنده تعالى عند توفيته أجرهم أو بحذف القول و التقدير و يقال لهم: إنّ هذا كان لكم جزاء إلخ.
و قوله:( وَ كانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً ) إنشاء شكر لمساعيهم المرضيّة و أعمالهم المقبولة، و يا لها من كلمة طيّبة تطيب بها نفوسهم.
و اعلم أنّه تعالى لم يذكر فيما ذكر من نعيم الجنّة في هذه الآيات نساء الجنّة من الحور العين و هي من أهمّ ما يذكره عند وصف نعم الجنّة في سائر كلامه و يمكن أن يستظهر منه أنّه كانت بين هؤلاء الأبرار الّذين نزلت فيهم الآيات من هي من النساء.
و قال في روح المعاني: و من اللطائف على القول بنزول السورة فيهم يعني في أهل البيت أنّه سبحانه لم يذكر فيها الحور العين و إنّما صرّح عزّوجلّ بولدان مخلّدين رعاية لحرمة البتول و قرّة عين الرسول، انتهى.
( بحث روائي)
في إتقان السيوطيّ، عن البيهقيّ في دلائل النبوّة بإسناده عن عكرمة و الحسن بن أبي الحسن قالا: أنزل الله من القرآن بمكّة اقرأ باسم ربّك و ن و المزّمّل - إلى أن قالا - و ما نزل بالمدينة ويل للمطفّفين، و البقرة، و آل عمران، و الأنفال، و الأحزاب، و المائدة، و الممتحنة، و النساء، و إذا زلزلت، و الحديد، و محمّد، و الرعد، و الرحمن، و هل أتى على الإنسان. الحديث.
و فيه، عن ابن الضريس في فضائل القرآن بإسناده عن عثمان بن عطاء الخراسانيّ
عن أبيه عن ابن عبّاس قال: كان إذا نزلت فاتحة سورة بمكّة كتبت بمكّة ثمّ يزيد الله فيها ما شاء.
و كان أوّل ما اُنزل من القرآن اقرأ باسم ربّك، ثمّ ن، ثمّ يا أيّها المزّمّل - إلى أن قال - ثمّ اُنزل بالمدينة سورة البقرة ثمّ الأنفال ثمّ آل عمران ثمّ الأحزاب ثمّ الممتحنة ثمّ النساء ثمّ إذا زلزلت ثمّ الحديد ثمّ القتال ثمّ الرعد ثمّ الرحمن ثمّ الإنسان. الحديث.
و فيه، عن البيهقيّ في الدلائل بإسناده عن مجاهد عن ابن عبّاس أنّه قال: إنّ أوّل ما أنزل الله على نبيّه من القرآن اقرأ باسم ربّك، و ذكر مثل حديث عكرمة و الحسين و فيه ذكر ثلاث من السور المكّيّة الّتي سقطت من روايتهما و هي الفاتحة و الأعراف و كهيعص.
و في الدرّ المنثور، أخرج ابن الضريس و ابن مردويه و البيهقيّ عن ابن عبّاس قال: نزلت سورة الإنسان بالمدينة.
و فيه، أخرج ابن مردويه عن ابن عبّاس في قوله تعالى:( وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ ) الآية قال: نزلت هذه الآية في عليّ بن أبي طالب و فاطمة بنت رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم .
أقول: الآية تشارك سائر آيات صدر السورة ممّا تقدّم عليها أو تأخّر عنها في سياق واحد متّصل فنزولها فيهماعليهالسلام لا ينفكّ نزولها جميعاً بالمدينة.
و في الكشّاف: و عن ابن عبّاس: أنّ الحسن و الحسين مرضاً فعادهما رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم في ناس معه فقالوا: يا أباالحسن لو نذرت على ولدك (ولديك ظ) فنذر عليّ و فاطمة و فضّة جارية لهما إن برءا ممّا بهما أن يصوموا ثلاثة أيّام فشفيا و ما معهم شيء.
فاستقرض عليّ من شمعون الخيبريّ اليهوديّ ثلاث أصوع من شعير فطحنت فاطمة صاعاً و اختبزت خمسة أقراص على عددهم فوضعوها بين أيديهم ليفطروا فوقف عليهم سائل و قال: السلام عليكم أهل بيت محمّد مسكين من مساكين المسلمين أطعموني
أطعمكم الله من موائد الجنّة فآثروه و باتوا لم يذوقوا إلّا الماء و أصبحوا صياماً.
فلمّا أمسوا و وضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتيم فآثروه، و وقف عليهم أسير في الثالثة ففعلوا مثل ذلك.
فلمّا أصبحوا أخذ عليّ بيد الحسن و الحسين و أقبلوا إلى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فلمّا أبصرهم و هم يرتعشون كالفراخ من شدّة الجوع قال: ما أشدّ ما يسوءني ما أرى بكم فانطلق معهم فرأى فاطمة في محرابها قد التصق ظهرها(1) ببطنها و غارت عيناها فساءه ذلك فنزل جبريل و قال: خذها يا محمّد هنّأك الله في أهل بيتك فأقرأه السورة.
أقول: الرواية مرويّة بغير واحد من الطرق عن عطاء عن ابن عبّاس و نقلها البحرانيّ في غاية المرام، عن أبي المؤيّد الموفّق بن أحمد في كتاب فضائل أميرالمؤمنين بإسناده عن مجاهد عن ابن عبّاس، و عنه بإسناد آخر عن الضحّاك عن ابن عبّاس و عن الحموينيّ في كتاب فرائد السمطين بإسناده عن مجاهد عن ابن عبّاس، و عن الثعلبيّ بإسناده عن أبي صالح عن ابن عبّاس، و رواه في المجمع، عن الواحدي في تفسيره.
و في المجمع، بإسناده عن الحاكم بإسناده عن سعيد بن المسيب عن عليّ بن أبي طالب أنّه قال سألت النبيّ عن ثواب القرآن: فأخبرني بثواب سورة سورة على نحو ما نزلت من السماء.
فأوّل ما نزل عليه بمكّة فاتحة الكتاب ثمّ اقرأ باسم ربّك، ثمّ ن - إلى أن قال - و أوّل ما نزل بالمدينة سورة البقرة ثمّ الأنفال ثمّ آل عمران ثمّ الأحزاب ثمّ الممتحنة ثمّ النساء ثمّ إذا زلزلت ثمّ الحديد ثمّ سورة محمّد ثمّ الرعد ثمّ سورة الرحمن ثمّ هل أتى. الحديث.
و فيه، عن أبي حمزة الثماليّ في تفسيره قال: حدّثني الحسن بن الحسن أبوعبدالله بن الحسن: أنّها مدنيّة نزلت في عليّ و فاطمة السورة كلّها.
و في تفسير القميّ، عن أبيه عن عبدالله بن ميمون عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: كان
____________________
(1) بطنها بظهرها ظ.
عند فاطمةعليهاالسلام شعير فجعلوه عصيدة(1) فلمّا أنضجوها و وضعوها بين أيديهم جاء مسكين فقال: مسكين رحمكم الله فقام عليّعليهالسلام فأعطاه ثلثاً فلم يلبث أن جاء يتيم فقال: اليتيم رحمكم الله فقام عليّعليهالسلام فأعطاه الثلث ثمّ جاء أسير فقال: الأسير رحمكم الله فأعطاه عليّعليهالسلام الثلث و ما ذاقوها فأنزل الله سبحانه الآيات فيهم و هي جارية في كلّ مؤمن فعل ذلك لله عزّوجلّ.
أقول: القصّة كما ترى ملخّصة في الرواية و روى ذلك البحراني في غاية المرام، عن المفيد في الاختصاص، مسنداً و عن ابن بابويه في الأمالي، بإسناده عن مجاهد عن ابن عبّاس، و بإسناده عن سلمة بن خالد عن جعفر بن محمّد عن أبيهعليهماالسلام ، و عن محمّد بن العبّاس بن ماهيار في تفسيره بإسناده عن أبي كثير الزبيريّ عن عبدالله بن عبّاس، و في المناقب، أنّه مرويّ عن الأصبغ بن نباتة.
و في الاحتجاج، عن عليّعليهالسلام : في حديث يقول فيه للقوم بعد موت عمر بن الخطّاب: نشدتكم بالله هل فيكم أحد نزل فيه و في ولده( إِنَّ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كانَ مِزاجُها كافُوراً ) إلى آخر السورة غيري؟ قالوا: لا.
و في كتاب الخصال، في احتجاج عليّ على أبي بكر قال: اُنشدك بالله أنا صاحب الآية( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ يَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً ) أم أنت؟ قال: بل أنت.
و في الدرّ المنثور، أخرج الطبرانيّ و ابن مردويه و ابن عساكر عن ابن عمر قال: جاء رجل من الحبشة إلى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فقال له رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : سل و استفهم فقال: يا رسول الله فضّلتم علينا بالألوان و الصور و النبوّة أ فرأيت إن آمنت بما آمنت به و عملت بمثل ما عملت به أنّي لكائن معك في الجنّة؟ قال: نعم و الّذي نفسي بيده إنّه ليرى بياض الأسود في الجنّة من مسيرة ألف عام. ثمّ قال: من قال لا إله إلّا الله كان له عهد عندالله و من قال: سبحان الله و بحمده كتبت له مائة ألف حسنة و أربعة و عشرون ألف حسنة و نزلت عليه السورة( هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ
____________________
(1) العصيدة: شعير يلت بالسمن و يطبخ.
الدَّهْرِ - إلى قوله -مُلْكاً كَبِيراً ) .
فقال الحبشيّ: و إنّ عيني لترى ما ترى عيناك في الجنّة؟ قال: نعم فاشتكى حتّى فاضت نفسه. قال عمر: فلقد رأيت رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم يدلّيه في حفرته بيده.
و فيه، أخرج أحمد في الزهد عن محمّد بن مطرف قال: حدّثني الثقة: أنّ رجلاً أسود كان يسأل النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم عن التسبيح و التهليل فقال له عمر بن الخطّاب: مه أكثرت على رسول الله فقال: مه يا عمر و اُنزلت على رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ( هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ ) حتّى إذا أتى على ذكر الجنّة زفر الأسود زفرة خرجت نفسه فقال النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم : مات شوقاً إلى الجنّة.
و فيه، أخرج ابن وهب عن ابن زيد أنّ رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم قرأ هذه السورة( هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ ) و قد اُنزلت عليه و عنده رجل أسود فلمّا بلغ صفة الجنان زفر زفرة فخرجت نفسه فقال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : أخرج نفس صاحبكم الشوق إلى الجنّة.
أقول: و هذه الروايات الثلاث على تقدير صحّتها لا تدلّ على أزيد من كون نزول السورة مقارناً لقصّة الرجل و أمّا كونها سبباً للنزول فلا، و هذا المعنى في الرواية الأخيرة أظهر و بالجملة لا تنافي الروايات الثلاث نزول السورة في أهل البيتعليهمالسلام .
على أنّ رواية ابن عمر للقصّة الظاهرة في حضوره القصّة و قد هاجر إلى المدينة و هو ابن إحدى عشرة سنة من شواهد وقوع القصّة بالمدينة.
و في الدرّ المنثور، أيضاً أخرج النحّاس عن ابن عبّاس قال: نزلت سورة الإنسان بمكّة.
أقول: هو تلخيص حديث طويل أورده النحّاس في كتاب النّاسخ و المنسوخ، و قد نقله في الإتقان و هو معارض لما تقدّم نقله مستفيضاً عن ابن عبّاس من نزول السورة بالمدينة و أنّها نزلت في أهل البيتعليهمالسلام .
على أنّ سياق آياتها و خاصّة قوله:( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ و يُطْعِمُونَ الطَّعامَ )
إلخ سياق قصّة واقعة و ذكر الأسير فيمن أطعموهم نعم الشاهد على نزول الآيات بالمدينة إذ لم يكن للمسلمين أسير بمكّة كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك.
قال بعضهم ما ملخّصه: أنّ الروايات مختلفة في مكّيّة هذه السورة و مدنيّتها و الأرجح أنّها مكّيّة بل الظاهر من سياقها أنّها من عتائق السور القرآنيّة النازلة بمكّة في أوائل البعثة يؤيّد ذلك ما ورد فيها من صور النعم الحسّيّة المفصّلة الطويلة و صور العذاب الغليظ كما يؤيّده ما ورد فيها من أمر النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم بالصبر لحكم ربّه و أن لا يطيع منهم آثماً أو كفوراً و يثبت على ما نزل عليه من الحقّ و لا يداهن المشركين من الأوامر الّتي كانت تنزّل بمكّة عند اشتداد الأذى على الدعوة و أصحابها بمكّة كما في سورة القلم و المزّمّل و المدّثّر فلا عبرة باحتمال مدنيّة السورة.
و هو فاسد أمّا ما ذكره من اشتمال السورة على صور النعم الحسّيّة المفصّلة الطويلة و صور العذاب الغليظ فليس ذلك ممّا يختصّ بالسور المكّيّة حتّى يقضى بها على كون السورة مكّيّة فهذه سورة الرحمن و سورة الحجّ مدنيّتان على ما تقدّمت في الروايات المشتملة على ترتيب نزول السور القرآنيّة و قد اشتملتا من صور النعم الحسّيّة المفصّلة الطويلة و صور العذاب الغليظ على ما يربو و يزيد على هذه السورة بكثير.
و أمّا ما ذكره من اشتمال السورة على أمر النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم بالصبر و أن لا يطيع منهم آثماً أو كفوراً و لا يداهنهم و يثبت على ما نزل عليه من الحقّ ففيه أنّ هذه الأوامر واقعة في الفصل الثاني من آيات السورة و هو قوله:( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ) إلى آخر السورة و من المحتمل جدّاً أن يكون هذا الفصل من الآيات - و هو ذو سياق تامّ مستقلّ - نازلاً بمكّة، و يؤيّده ما في كثير من الروايات المتقدّمة أنّ الّذي نزل في أهل البيت بالمدينة هو الفصل الأوّل من الآيات، و على هذا أوّل السورة مدنيّ و آخرها مكّيّ.
و لو سلّم نزولها دفعة واحدة فأمرهصلىاللهعليهوآلهوسلم بالصبر لا اختصاص له بالسور المكّيّة فقد ورد في قوله:( وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَ لا تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ لا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَ اتَّبَعَ هَواهُ وَ كانَ أَمْرُهُ فُرُطاً ) الكهف: 28 و الآية - على ما روي - مدنيّة و الآية - كما ترى - متّحدة المعنى مع قوله:( فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ) إلخ و هي في سياق شبيه جدّاً بسياق هذه الآيات فراجع و تأمّل.
ثمّ الّذي كان يلقاه النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم من أذى المنافقين و الّذين في قلوبهم مرض و الجفاة من ضعفاء الإيمان لم يكن بأهون من أذى المشركين بمكّة يشهد بذلك أخبار سيرته.
و لا دليل أيضاً على انحصار الإثم و الكفور في مشركي مكّة فهناك غيرهم من الكفّار و قد أثبت القرآن الإثم لجمع من المسلمين في موارد كقوله:( لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ) النور: 11، و قوله:( وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً ) النساء: 112.
و في المجمع، و روى العيّاشيّ بإسناده عن عبدالله بن بكير عن زرارة قال: سألت أباجعفرعليهالسلام عن قوله:( لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً ) قال: كان شيئاً و لم يكن مذكوراً.
أقول: و روي فيه، أيضاً عن عبدالأعلى مولى آل سام عن أبي عبداللهعليهالسلام : مثله.
و فيه، أيضاً عن العيّاشيّ بإسناده عن سعيد الحذّاء عن أبي جعفرعليهالسلام قال: كان مذكوراً في العلم و لم يكن مذكوراً في الخلق.
أقول: يعني أنّه كان له ثبوت في علم الله ثمّ خلق بالفعل فصار مذكوراً فيمن خلق.
و في الكافي، بإسناده عن مالك الجهنيّ عن أبي عبداللهعليهالسلام في الآية قال: كان مقدّراً غير مذكور.
أقول: هو في معنى الحديث السابق.
و في تفسير القمّيّ: في الآية قال: لم يكن في العلم و لا في الذكر، و في حديث آخر: كان في العلم و لم يكن في الذكر.
أقول: معنى الحديث الأوّل أنّه لم يكن في علم الناس و لا فيمن يذكرونه فيما بينهم، و معنى الثاني أنّه كان في علم الله و لم يكن مذكوراً عند الناس.
و في تفسير القمّيّ، أيضاً في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرعليهالسلام في قوله تعالى( أَمْشاجٍ نَبْتَلِيهِ ) قال: ماء الرجل و المرأة اختلطا جميعاً.
و في الكافي، بإسناده عن حمران بن أعين قال: سألت أباعبداللهعليهالسلام عن قوله عزّوجلّ:( إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً ) قال: إمّا آخذ فهو شاكر و إمّا تارك فهو كافر.
أقول: و رواه القمّيّ في تفسيره، بإسناده عن ابن أبي عمير عن أبي جعفرعليهالسلام مثله، و في التوحيد، بإسناده إلى حمزة بن الطيّار عن أبي عبداللهعليهالسلام ما يقرب منه و لفظه: عرّفناه إمّا آخذاً و إمّا تاركاً.
و في الدرّ المنثور، أخرج أحمد و ابن المنذر عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : كلّ مولود يولد على الفطرة حتّى يعبّر عنه لسانه فإذا عبّر عنه لسانه إمّا شاكراً و إمّا كفوراً و الله تعالى أعلم.
و في أمالي الصدوق، بإسناده عن الصادق عن أبيهعليهماالسلام في حديث:( عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللهِ يُفَجِّرُونَها تَفْجِيراً ) قال: هي عين في دار النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم يفجر إلى دور الأنبياء و المؤمنين( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ) يعني عليّاً و فاطمة و الحسن و الحسينعليهمالسلام و جاريتهم( وَ يَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً ) يقول عابساً كلوحاً( وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ ) يقول: على شهوتهم للطعام و إيثارهم له( مِسْكِيناً ) من مساكين المسلمين( وَ يَتِيماً ) من يتامى المسلمين( وَ أَسِيراً ) من اُسارى المشركين.
و يقولون إذا أطعموهم:( إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ لا شُكُوراً ) قال: و الله ما قالوا هذا لهم و لكنّهم أضمروه في أنفسهم فأخبر الله بإضمارهم يقولون: لا نريد جزاءً تكافئوننا به و لا شكوراً تثنون علينا به، و لكنّا إنّما أطعمناكم لوجه الله و طلب ثوابه.
و في الدرّ المنثور، أخرج سعيد بن منصور و ابن أبي شيبة و ابن المنذر و ابن
مردويه عن الحسن قال: كان الاُسارى مشركين يوم نزلت هذه الآية( وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً ) .
أقول: مدلول الرواية نزول الآية بالمدينة، و نظيرها ما رواه فيه عن عبد بن حميد عن قتادة، و ما رواه عن ابن المنذر عن ابن جريح، و ما رواه عن عبدالرزّاق و ابن المنذر عن ابن عبّاس.
و فيه، أخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك عن النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم في قوله:( يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً ) قال: يقبض ما بين الأبصار.
و في روضة الكافي، بإسناده عن محمّد بن إسحاق المدنيّ عن أبي جعفرعليهالسلام في صفة الجنّة قال: و الثمار دانية منهم و هو قوله عزّوجلّ:( وَ دانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُها وَ ذُلِّلَتْ قُطُوفُها تَذْلِيلًا ) من قربها منهم يتناول المؤمن من النوع الّذي يشتهيه من الثمار بفيه و هو متكّئ و إنّ الأنواع من الفاكهة ليقلن لوليّ الله: يا وليّ الله كلمني قبل أن تأكل هذه قبلي.
و في تفسير القمّيّ: في قوله:( وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ ) قال: مسوّرون.
و في المعاني، بإسناده عن عبّاس بن يزيد قال: قلت لأبي عبداللهعليهالسلام و كنت عنده ذات يوم: أخبرني عن قول الله عزّوجلّ:( وَ إِذا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَ مُلْكاً كَبِيراً ) ما هذا الملك الّذي كبّر الله عزّوجلّ حتّى سمّاه كبيراً؟ قال: إذا أدخل الله أهل الجنّة الجنّة أرسل رسولاً إلى وليّ من أوليائه فيجد الحجبة على بابه فتقول له: قف حتّى نستأذن لك، فما يصل إليه رسول ربّه إلّا بإذن فهو قوله عزّوجلّ:( وَ إِذا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَ مُلْكاً كَبِيراً ) .
و في المجمع:( وَ إِذا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَ مُلْكاً كَبِيراً ) لا يزول و لا يفنى: عن الصادقعليهالسلام .
و فيه:( عالِيَهُمْ ثِيابُ سُندُسٍ خُضْرٌ ) و روي عن الصادقعليهالسلام في معناه: تعلوهم الثياب فيلبسونها.
( كلام في هوية الإنسان على ما يفيده القرآن)
لا ريب أن في هذا الهيكل المحسوس الّذي نسمّيه إنساناً مبدءً للحياة ينتسب إليه الشعور و الإرادة، و قد عبّر تعالى عنه في الكلام في خلق الإنسان - آدم - بالروح و في سائر المواضع من كلامه بالنفس قال تعالى:( فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ ) الحجر: 29، ص: 72، و قال:( ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ) الم السجدة: 9.
و الّذي يسبق من الآيتين إلى النظر البادئ أنّ الروح و البدن حقيقتان اثنتان متفارقتان نظير العجين المركّب من الماء و الدقيق و الإنسان مجموع الحقيقتين فإذا قارنت الروح الجسد كان إنساناً حيّاً و إذا فارقت فهو الموت.
لكن يفسّرها قوله تعالى:( قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ) الم السجدة: 11 حيث يفيد أنّ الروح الّتي يتوفّاها و يأخذها قابض الأرواح هي الّتي يعبّر عنها بلفظة( كم ) و هو الإنسان بتمام حقيقته لا جزء من مجموع فالمراد بنفخ الروح في الجسد جعل الجسد بعينه إنساناً لا ضمّ واحد إلى واحد آخر يغايره في ذاته و آثار ذاته فالإنسان حقيقة واحدة حين تعلّق روحه ببدنه و بعد مفارقة روحه البدن.
و يفيد هذا المعنى قوله تعالى:( وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ ) المؤمنون: 14 فالّذي أنشأه الله خلقاً آخر هو النطفة الّتي تكوّنت علقة ثمّ مضغة ثمّ عظاماً بعينها.
و في معناها قوله تعالى:( هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً ) فتقييد الشيء المنفي بالمذكور يعطي أنّه كان شيئاً لكن لم يكن مذكوراً
فقد كان أرضاً أو نطفة مثلاً لكن لم يكن مذكوراً أنّه الإنسان الفلانيّ ثمّ صار هو هو.
فمفاد كلامه تعالى أنّ الإنسان واحد حقيقيّ هو المبدأ الوحيد لجميع آثار البدن الطبيعيّة و الآثار الروحيّة كما أنّه مجرّد في نفسه عن المادّة كما يفيده أمثال قوله تعالى:( قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ ) و قوله:( اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها ) الزمر: 42 و قوله:( ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ ) و قد تقدّم بيانه.
( سورة الإنسان الآيات 23 - 31)
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا ( 23 ) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ( 24 ) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ( 25 ) وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ( 26 ) إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ( 27 ) نَّحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ( 28 ) إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ( 29 ) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ( 30 ) يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ( 31 )
( بيان)
لمّا وصف جزاء الأبرار و ما قدّر لهم من النعيم المقيم و الملك العظيم بما صبروا في جنب الله وجّه الخطاب إلى النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم و أمره بالصبر لحكم ربّه و أن لا يطيع هؤلاء الآثمين و الكفّار المحبّين للعاجلة المتعلّقين بها المعرضين عن الآخرة من المشركين و سائر الكفّار و المنافقين و أهل الأهواء، و أن يذكر اسم ربّه و يسجد له و يسبّحه مستمرّاً عليه ثمّ عمّم الحكم لاُمّته بقوله:( إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلًا ) .
فهذا وجه اتّصال الآيات بما قبلها و سياقها مع ذلك لا يخلو من شبه بالسياقات المكّيّة و على تقدير مكّيّتها فصدر السورة مدنيّ و ذيلها مكّيّ.
قوله تعالى: ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ) تصدير الكلام بأنّ و تكرار ضمير المتكلّم مع الغير و الإتيان بالمفعول المطلق كلّ ذلك للتأكيد، و لتسجيل أنّ الّذي نزل من القرآن نجوماً متفرّقة هو من الله سبحانه لم يداخله نفث شيطانيّ و لا هو نفسانيّ.
قوله تعالى: ( فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ لا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً ) تفريع على ما هو لازم مضمون الآية السابقة فإنّ لازم كون الله سبحانه هو الّذي نزّل القرآن عليه أن يكون ما في القرآن من الحكم حكم ربّه يجب أن يطاع فالمعنى إذا كان تنزيله منّا فما فيه من الحكم حكم ربّك فيجب عليك أن تصبر له فاصبر لحكم ربّك.
و قوله:( وَ لا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً ) ورود الترديد في سياق النهي يفيد عموم الحكم فالنهي عن طاعتهما سواء اجتمعا أو افترقا، و الظاهر أنّ المراد بالإثم المتلبّس بالمعصية و بالكفور المبالغ في الكفر فتشمل الآية الكفّار و الفساق جميعاً.
و سبق النهي عن طاعة الإثم و الكفور بالأمر بالصبر لحكم ربّه يفيد كون النهي مفسّراً للأمر فمفاد النهي أن لا تطع منهم آثماً إذا دعاك إلى إثمه و لا كفوراً إذا دعاك إلى كفره لأنّ إثم الآثم منهم و كفر الكافر مخالفان لحكم ربّك و أمّا تعليق الحكم بالوصف المشعر بالعلّيّة فإنّما يفيد علّيّة الإثم و الكفر للنهي عن الطاعة مطلقاً لا علّيّتهما للنهي إذا دعا الآثم إلى خصوص إثمه و الكافر إلى خصوص كفره.
قوله تعالى: ( وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا ) أي داوم على ذكر ربّك و هو الصلاة في كلّ بكرة و أصيل و هما الغدوّ و العشيّ.
قوله تعالى: ( وَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَ سَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ) من للتبعيض و المراد بالسجود له الصلاة، و يقبل ما في الآيتين من ذكر اسمه بكرة و أصيلاً و السجود
له بعض الليل الانطباق على صلاة الصبح و العصر و المغرب و العشاء و هذا يؤيّد نزول الآيات بمكّة قبل فرض الفرائض الخمس بقوله في آية الإسراء:( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ ) إسراء: 78.
فالآيتان كقوله تعالى:( وَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ ) هود: 114، و قوله:( وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِها وَ مِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَ أَطْرافَ النَّهارِ ) طه: 130.
نعم قيل: إنّ الأصيل يطلق على ما بعد الزوال فيشمل قوله:( وَ أَصِيلًا ) وقتي صلاتي الظهر و العصر جميعاً، و لا يخلو من وجه.
و قوله:( وَ سَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ) أي في ليل طويل و وصف الليل بالطويل توضيحيّ لا احترازيّ، و المراد بالتسبيح صلاة الليل، و احتمل أن يكون طويلاً صفة لمفعول مطلق محذوف، و التقدير سبّحه في الليل تسبيحاً طويلاً.
قوله تعالى: ( إِنَّ هؤُلاءِ يُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ وَ يَذَرُونَ وَراءَهُمْ يَوْماً ثَقِيلًا ) تعليل لما تقدّم من الأمر و النهي و الإشارة بهؤلاء إلى جمع الإثم و الكفور المدلول عليه بوقوع النكرة في سياق النهي، و المراد بالعاجلة الحياة الدنيا، و عدّ اليوم ثقيلاً من الاستعارة، و المراد بثقله شدّته كأنّه محمول ثقيل يشقّ حمله، و اليوم يوم القيامة.
و كون اليوم وراءهم تقرّره أمامهم لأنّ وراء تفيد معنى الإحاطة، أو جعلهم إيّاه خلفهم و وراء ظهورهم بناء على إفادة( يَذَرُونَ ) معنى الإعراض.
و المعنى: فاصبر لحكم ربّك و أقم الصلاة و لا تطع الآثمين و الكفّار منهم لأنّ هؤلاء الآثمين و الكفّار يحبّون الحياة الدنيا فلا يعملون إلّا لها و يتركون أمامهم يوماً شديداً أو يعرضون فيجعلون خلفهم يوماً شديداً سيلقونه.
قوله تعالى: ( نَحْنُ خَلَقْناهُمْ وَ شَدَدْنا أَسْرَهُمْ وَ إِذا شِئْنا بَدَّلْنا أَمْثالَهُمْ تَبْدِيلًا ) الشدّ خلاف الفكّ، و الأسر في الأصل الشدّ و الربط و يطلق على ما يشدّ و يربط به فمعنى شددنا أسرهم أحكمنا ربط مفاصلهم بالرباطات و الأعصاب و العضلات أو الأسر
بمعنى المأسور و المعنى أحكمنا ربط أعضائهم المختلفة المشدودة بعضها ببعض حتّى صار الواحد منهم بذلك إنساناً واحداً.
و قوله:( وَ إِذا شِئْنا بَدَّلْنا أَمْثالَهُمْ تَبْدِيلًا ) أي إذا شئنا بدّلناهم أمثالهم فذهبنا بهم و جئنا بأمثالهم مكانهم و هو إماته قرن و إحياء آخرين، و قيل: المراد به تبديل نشأتهم الدنيا من نشأة القيامة و هو بعيد من السياق.
و الآية في معنى دفع الدخل كان متوهّماً يتوهّم أنّهم بحبّهم للدنيا و إعراضهم عن الآخرة يعجزونه تعالى و يفسدون عليه إرادته منهم أن يؤمنوا و يطيعوا فاُجيب بأنّهم مخلوقون لله خلقهم و شدّ أسرهم و إذا شاء أذهبهم و جاء بآخرين فكيف يعجزونه و خلقهم و أمرهم و حياتهم و موتهم بيده.؟
قوله تعالى: ( إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلًا ) تقدّم تفسيره في سورة المزّمّل و الإشارة بهذه إلى ما ذكر في السورة.
قوله تعالى: ( وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً ) الاستثناء من النفي يفيد أنّ مشيّة العبد متوقّفة في وجودها على مشيّته تعالى فلمشيّته تعالى تأثير في فعل العبد من طريق تعلّقها بمشيّة العبد، و ليست متعلّقة بفعل العبد مستقلّاً و بلا واسطة حتّى تستلزم بطلان تأثير إرادة العبد و كون الفعل جبريّاً و لا أنّ العبد مستقلّ في إرادة يفعل ما يشاؤه شاء الله أو لم يشأ، فالفعل اختياريّ لاستناده إلى اختيار العبد، و أمّا اختيار العبد فليس مستنداً إلى اختيار آخر، و قد تكرّر توضيح هذا البحث في مواضع ممّا تقدّم.
و الآية مسوقة لدفع توهّم أنّهم مستقلّون في مشيّتهم منقطعون من مشيّة ربّهم، و لعلّ تسجيل هذا التنبيه عليهم هو الوجه في الالتفات إلى الخطاب في قوله( وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ ) كما أنّ الوجه في الالتفات من التكلّم بالغير إلى الغيبة في قوله:( يَشاءَ اللهُ إِنَّ اللهَ ) هو الإشارة إلى علّة الحكم فإنّ مسمّى هذا الاسم الجليل يبتدئ منه كلّ شيء و ينتهي إليه كلّ شيء فلا تكون مشيّة إلّا بمشيّته
و لا تؤثّر مشيّة إلّا بإذنه.
و قوله:( إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً ) توطئة لبيان مضمون الآية التالية.
قوله تعالى: ( يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَ الظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً ) مفعول( يَشاءُ ) محذوف يدلّ عليه الكلام، و التقدير يدخل في رحمته من يشاء دخوله في رحمته، و لا يشاء إلّا دخول من آمن و اتّقى، و أمّا غيرهم و هم أهل الإثم و الكفر فبيّن حالهم بقوله:( وَ الظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً ) .
و الآية تبيّن سنّته تعالى الجارية في عباده من حيث السعادة و الشقاء، و قد علّل ذلك بما في ذيل الآية السابقة من قوله( إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً ) فأفاد به أنّ سنّته تعالى ليست سنّة جزافيّة مبنيّة على الجهالة بل هو يعامل كلّاً من الطائفتين بما هو أهل له و سينبّئهم حقيقة ما كانوا يعملون.
( بحث روائي)
و في الدرّ المنثور، أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله:( وَ لا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً ) قال: حدّثنا أنّها نزلت في عدوّ الله أبي جهل.
أقول: و هو أشبه بالتطبيق.
و في المجمع في قوله تعالى:( وَ سَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ) روي عن الرضاعليهالسلام : أنّه سأله أحمد بن محمّد عن هذه الآية و قال: ما ذلك التسبيح؟ قال: صلاة الليل.
و في الخرائج و الجرائح، عن القائمعليهالسلام : في حديث يقول لكامل بن إبراهيم المدنيّ: و جئت تسأل عن مقالة المفوّضة كذبوا بل قلوبنا أوعية لمشيّة الله عزّوجلّ فإذا شاء شئنا، و الله يقول( وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ ) .
و في الدرّ المنثور، أخرج ابن مردويه من طريق ابن شهاب عن سالم عن أبي هريرة أنّ رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم كان يقول إذا خطب: كلّ ما هو آت قريب، لا بعد لما
يأتي، و لا يعجل الله لعجلة أحد، ما شاء الله لا ما شاء الناس، يريد الناس أمراً و يريد الله أمراً، ما شاء الله كان و لو كره الناس، لا مباعد لما قرّب الله، و لا مقرّب لما باعد الله، لا يكون شيء إلّا بإذن الله.
أقول: و في بعض الروايات من طرق أهل البيتعليهمالسلام تطبيق الحكم في قوله:( فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ) و الرحمة في قوله:( يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ ) على الولاية و هو من الجري أو البطن و ليس من التفسير في شيء.
( سورة المرسلات مكّيّة و هي خمسون آية)
( سورة المرسلات الآيات 1 - 15)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ( 1 ) فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ( 2 ) وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ( 3 ) فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا ( 4 ) فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ( 5 ) عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ( 6 ) إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ( 7 ) فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ( 8 ) وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ( 9 ) وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ( 10 ) وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ ( 11 ) لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ( 12 ) لِيَوْمِ الْفَصْلِ ( 13 ) وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ( 14 ) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ( 15 )
( بيان)
تذكر السورة يوم الفصل و هو يوم القيامة و تؤكّد الإخبار بوقوعه و تشفّعه بالوعيد الشديد للمكذّبين به و الإنذار و التبشير لغيرهم و يربو فيها جانب الوعيد على غيره فقد كرّر فيها قوله:( وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ) عشر مرّات.
و السورة مكّيّة بشهادة سياق آياتها.
قوله تعالى: ( وَ الْمُرْسَلاتِ عُرْفاً ) الآية و ما يتلوها إلى تمام ستّ آيات إقسام منه تعالى باُمور يعبّر عنها بالمرسلات فالعاصفات و الناشرات فالفارقات فالملقيات ذكراً عذراً أو نذراً، و الاُوليان أعني المرسلات عرفاً و العاصفات عصفاً لا تخلوان لو خلّيتا و نفسهما مع الغضّ عن السياق من ظهور ما في الرياح المتعاقبة الشديدة الهبوب لكنّ الأخيرة أعني الملقيات ذكراً عذراً أو نذراً كالصريحة في الملائكة النازلين على الرسل الحاملين لوحي الرسالة الملقين له إليهم إتماماً للحجّة أو إنذاراً و بقيّة الصفات
لا تأبى الحمل على ما يناسب هذا المعنى.
و حمل جميع الصفات الخمس على إرادة الرياح كما هو ظاهر المرسلات و العاصفات - على ما عرفت - يحتاج إلى تكلّف شديد في توجيه الصفات الثلاث الباقية و خاصّة في الصفة الأخيرة.
و كذا حمل المرسلات و العاصفات على إرادة الرياح و حمل الثلاث الباقية أو الأخيرتين أو الأخيرة فحسب على ملائكة الوحي إذ لا تناسب ظاهراً بين الرياح و بين ملائكة الوحي حتّى يقارن بينها في الأقسام و ينظم الجميع في سلك واحد، و ما وجّهوه من مختلف التوجيهات معان بعيدة عن الذهن لا ينتقل إليها في مفتتح الكلام من غير تنبيه سابق.
فالوجه هو الغضّ عن هذه الأقاويل و هي كثيرة جدّاً لا تكاد تنضبط، و حمل المذكورات على إرادة ملائكة الوحي كنظيرتها في مفتتح سورة الصافّات:( وَ الصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِراتِ زَجْراً فَالتَّالِياتِ ذِكْراً ) و في معناها قوله تعالى:( عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسالاتِ رَبِّهِمْ ) الجنّ: 28.
فقوله:( وَ الْمُرْسَلاتِ عُرْفاً ) إقسام منه تعالى بها و العرف بالضمّ فالسكون الشعر النابت على عنق الفرس و يشبّه به الاُمور إذا تتابعت يقال: جاؤا كعرف الفرس، و يستعار فيقال: جاء القطا عرفاً أي متتابعة و جاؤا إليه عرفاً واحداً أي متتابعين، و العرف أيضاً المعروف من الأمر و النهي و( عُرْفاً ) حال بالمعنى الأوّل مفعول له بالمعنى الثاني، و الإرسال خلاف الإمساك، و تأنيث المرسلات باعتبار الجماعات أو باعتبار الروح الّتي تنزّل بها الملائكة قال تعالى:( يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ ) النحل: 2 و قال( يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ ) المؤمن: 15.
و المعنى اُقسم بالجماعات المرسلات من ملائكة الوحي.
و قيل: المراد بالمرسلات عرفاً الرياح المتتابعة المرسلة و قد تقدّمت الإشارة إلى
ضعفه، و مثله في الضعف القول بأنّ المراد بها الأنبياءعليهمالسلام فلا يلائمه ما يتلوها.
قوله تعالى: ( فَالْعاصِفاتِ عَصْفاً ) عطف على المرسلات و المراد بالعصف سرعة السير استعارة من عصف الرياح إي سرعة هبوبها إشارة إلى سرعة سيرها إلى ما اُرسلت إليه، و المعنى اُقسم بالملائكة الّذين يرسلون متتابعين فيسرعون في سيرهم كالرياح العاصفة.
قوله تعالى: ( وَ النَّاشِراتِ نَشْراً ) إقسام آخر، و نشر الصحيفة و الكتاب و الثوب و نحوها: بسطه، و المراد بالنشر نشر صحف الوحي كما يشير إليه قوله تعالى( كَلَّا إِنَّها تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرامٍ بَرَرَةٍ ) عبس: 16 و المعنى و اُقسم بالملائكة الناشرين للصحف المكتوبة عليها الوحي للنبيّ ليتلقّاه.
و قيل: المراد بها الرياح ينشرها الله تعالى بين يدي رحمته و قيل: الرياح الناشرة للسحاب، و قيل: الملائكة الناشرين لصحائف الأعمال، و قيل: الملائكة نشروا أجنحتهم حين النزول و قيل: غير ذلك.
قوله تعالى: ( فَالْفارِقاتِ فَرْقاً ) المراد به الفرق بين الحقّ و الباطل و بين الحلال و الحرام، و الفرق المذكور صفة متفرّعة على النشر المذكور.
قوله تعالى: ( فَالْمُلْقِياتِ ذِكْراً عُذْراً أَوْ نُذْراً ) المراد بالذكر القرآن يقرؤنه على النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم أو مطلق الوحي النازل على الأنبياء المقروّ عليهم.
و الصفات الثلاث أعني النشر و الفرق و إلقاء مترتّبة فإنّ الفرق بين الحقّ و الباطل و الحلال و الحرام يتحقّق بنشر الصحف و إلقاء الذكر فبالنشر يشرع الفرق في التحقّق و بالتلاوة يتمّ تحقّقه فالنشر يترتّب عليه مرتبة من وجود الفرق و يترتّب عليها تمام وجوده بالإلقاء.
و قوله:( عُذْراً أَوْ نُذْراً ) هما من المفعول له و( أَوْ ) للتنويع قيل: هما مصدران بمعنى الإعذار و الإنذار، و الإعذار الإتيان بما يصير به معذوراً و المعنى أنّهم يلقون الذكر لتكون عذرا لعباده المؤمنين بالذكر و تخويفاً لغيرهم.
و قيل: ليكون عذراً يعتذر به الله إلى عباده في العقاب أنّه لم يكن إلّا على وجه الحكمة، و يؤل إلى إتمام الحجّة، فمحصّل المعنى عليه أنّهم يلقون الذكر ليكون إتماماً للحجّة على المكذّبين و تخويفاً لغيرهم، و هو معنى حسن.
قوله تعالى: ( إِنَّما تُوعَدُونَ لَواقِعٌ ) جواب القسم، و ما موصولة و الخطاب لعامّة البشر، و المراد بما توعدون يوم القيامة بما فيه من العقاب و الثواب و الواقع أبلغ من الكائن لما فيه من شائبة الاستقرار، و المعنى أنّ الّذي وعدكم الله به من البعث و العقاب و الثواب سيتحقّق لا محالة.
( كلام في إقسامه تعالى في القرآن)
من لطيف صنعة البيان في هذه الآيات الستّ أنّها مع ما تتضمّن الإقسام لتأكيد الخبر الّذي في الجواب تتضمّن الحجّة على مضمون الجواب و هو وقوع الجزاء الموعود فإنّ التدبير الربوبيّ الّذي يشير إليه القسم أعني إرسال المرسلات العاصفات و نشرها الصحف و فرقها و إلقاءها الذكر للنبيّ تدبير لا يتمّ إلّا مع وجود التكليف الإلهيّ و التكليف لا يتمّ إلّا مع تحتّم وجود يوم معدّ للجزاء يجازى فيه العاصي و المطيع من المكلّفين.
فالّذي أقسم تعالى به من التدبير لتأكيد وقوع الجزاء الموعود هو بعينه حجّة على وقوعه كأنّه قيل: اُقسم بهذه الحجّة أنّ مدلولها واقع.
و إذا تأمّلت الموارد الّتي اُورد فيها القسم في كلامه تعالى و أمعنت فيها وجدت المقسم به فيها حجّة دالّة على حقّيّة الجواب كقوله تعالى في الرزق:( فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ ) الذاريات: 23 فإنّ ربوبيّة السماء و الأرض هي المبدأ لرزق المرزوقين، و قوله:( لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ) الحجر: 72 فإنّ حياة النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم الطاهرة المصونة بعصمة من الله دالّة على سكرهم و عمههم، و قوله:( وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها - إلى أن قال -وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها قَدْ
أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها ) الشمس: 10 فإنّ هذا النظام المتقن المنتهي إلى النفس الملهمة المميّزة لفجورها و تقواها هو الدليل على فلاح من زكّاها و خيبة من دسّاها.
و على هذا النسق سائر ما ورد من القسم في كلامه تعالى و إن كان بعضها لا يخلو من خفاء يحوج إلى إمعان من النظر كقوله:( وَ التِّينِ وَ الزَّيْتُونِ وَ طُورِ سِينِينَ ) التين: 2 و عليك بالتدبّر فيها.
قوله تعالى: ( فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ - إلى قوله -أُقِّتَتْ ) بيان لليوم الموعود الّذي اُخبر بوقوعه في قوله:( إِنَّما تُوعَدُونَ لَواقِعٌ ) و جواب إذا محذوف يدلّ عليه قوله:( لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ - إلى قوله -لِلْمُكَذِّبِينَ ) .
و قد عرّف سبحانه اليوم الموعود بذكر حوادث واقعة تلازم انقراض العالم الإنسانيّ و انقطاع النظام الدنيويّ كانطماس النجوم و انشقاق الأرض و اندكاك الجبال و تحوّل النظام إلى نظام آخر يغايره، و قد تكرّر ذلك في كثير من السور القرآنيّة و خاصّة السور القصار كسورة النبإ و النازعات و التكوير و الانفطار و الانشقاق و الفجر و الزلزال و القارعة، و غيرها، و قد عدّت الاُمور المذكورة فيها في الأخبار من أشراط الساعة.
و من المعلوم بالضرورة من بيانات الكتاب و السنّة أنّ نظام الحياة في جميع شؤنها في الآخرة غير نظامها في الدنيا فالدار الآخرة دار أبديّة فيها محض السعادة لساكنيها لهم فيها ما يشاؤن أو محض الشقاء و ليس لهم فيها إلّا ما يكرهون و الدار الدنيا دار فناء و زوال لا يحكم فيها إلّا الأسباب و العوامل الخارجيّة الظاهريّة مخلوط فيها الموت بالحياة، و الفقدان بالوجدان، و الشقاء بالسعادة، و التعب بالراحة، و المساءة بالسرور، و الآخرة دار جزاء و لا عمل و الدنيا دار عمل و لا جزاء، و بالجملة النشأة غير النشأة.
فتعريفه تعالى نشأة البعث و الجزاء بأشراطها الّتي فيها انطواء بساط الدنيا
بخراب بنيان أرضها و انتساف جبالها و انشقاق سمائها و انطماس نجومها إلى غير ذلك من قبيل تحديد نشأة بسقوط النظام الحاكم في نشأة اُخرى قال تعالى:( وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولى فَلَوْ لا تَذَكَّرُونَ ) الواقعة: 62.
فقوله:( فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ) أي محي أثرها من النور و غيره، و الطمس إزالة الأثر بالمحو قال تعالى:( وَ إِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ) التكوير: 2.
و قوله:( وَ إِذَا السَّماءُ فُرِجَتْ ) أي انشقّت، و الفرج و الفرجة الشقّ بين الشيئين قال تعالى:( إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ ) الانشقاق: 1.
و قوله:( وَ إِذَا الْجِبالُ نُسِفَتْ ) أي قلعت و اُزيلت من قولهم: نسفت الريح الشيء أي اقتلعته و أزالته قال تعالى:( وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبالِ فَقُلْ يَنْسِفُها رَبِّي نَسْفاً ) طه: 105.
و قوله:( وَ إِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ ) أي عيّن لها الوقت الّذي تحضر فيه للشهادة على الاُمم أو بلغت الوقت الّذي تنتظره لأداء شهادتها على الاُمم من التأقيت بمعنى التوقيت، قال تعالى:( فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَ لَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ) الأعراف: 6، و قال:( يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ ما ذا أُجِبْتُمْ ) المائدة: 109.
قوله تعالى: ( لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ - إلى قوله -لِلْمُكَذِّبِينَ ) الأجل المدّة المضروبة للشيء، و التأجيل جعل الأجل للشيء، و يستعمل في لازمه و هو التأخير كقولهم: دين مؤجّل أي له مدّة بخلاف الحالّ و هذا المعنى هو الأنسب للآية، و الضمير في( أُجِّلَتْ ) للاُمور المذكورة قبلاً من طمس النجوم و فرج السماء و نسف الجبال و تأقيت الرسل، و المعنى لأيّ يوم اُخّرت يوم اُخّرت هذه الاُمور.
و احتمل أن يكون( أُجِّلَتْ ) بمعنى ضرب الأجل للشيء و أن يكون الضمير المقدّر فيه راجعاً إلى الرسل، أو إلى ما يشعر به الكلام من الاُمور المتعلّقة بالرسل ممّا أخبروا به من أحوال الآخرة و أهوالها و تعذيب الكافرين و تنعيم المؤمنين فيها، و لا يخلو كلّ ذلك من خفاء.
و قد سيقت الآية و الّتي بعدها أعني قوله:( لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ) في
صورة الاستفهام و جوابه للتعظيم و التهويل و التعجيب و أصل المعنى اُخّرت هذه الاُمور ليوم الفصل.
و هذا النوع من الجمل الاستفهاميّة في معنى تقدير القول، و المعنى إنّ من عظمة هذا اليوم و هوله و كونه عجباً أنّه يسأل فيقال: لأيّ يوم اُخّرت هذه الاُمور العظيمة الهائلة العجيبة فيجاب: ليوم الفصل.
و قوله:( لِيَوْمِ الْفَصْلِ ) هو يوم الجزاء الّذي فيه فصل القضاء قال تعالى:( إِنَّ اللهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) الحجّ: 17.
و قوله:( وَ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الْفَصْلِ ) تعظيم لليوم و تفخيم لأمره.
و قوله:( وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ) الويل الهلاك، و المراد بالمكذّبين المكذّبون بيوم الفصل الّذي فيه ما يوعدون فإنّ الآيات مسوقة لبيان وقوعه و قد أقسم على أنّه واقع.
و في الآية دعاء على المكذّبين، و قد استغنى به عن ذكر جواب إذا في قوله:( فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ) إلخ و التقدير فإذا كان كذا و كذا وقع ما توعدون من العذاب على التكذيب أو التقدير فإذا كان كذا و كذا كان يوم الفصل و هلك المكذّبون به.
( بحث روائي)
في الخصال، عن ابن عبّاس قال: قال أبوبكر: أسرع الشيب إليك يا رسول الله قالصلىاللهعليهوآلهوسلم : شيّبتني هود و الواقعة و المرسلات و عمّ يتساءلون.
و في الدرّ المنثور، أخرج البخاريّ و مسلم و النسائيّ و ابن مردويه عن ابن مسعود قال: بينما نحن مع النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم في غار بمنى إذ نزلت عليه سورة و المرسلات عرفاً فإنّه يتلوها و إنّي لألقاها من فيه و إنّ فاه لرطب بها إذ وثبت عليه حيّة فقال النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم : اقتلوها فابتدرناها فذهبت فقال النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم وقيت شرّكم كما وقيتم شرّها.
أقول: و رواها أيضاً بطريقين آخرين.
و في تفسير القمّيّ في قوله تعالى:( وَ الْمُرْسَلاتِ عُرْفاً ) قال: آيات تتبع بعضها بعضاً.
و في المجمع: في الآية و قيل: إنّها الملائكة اُرسلت بالمعروف من أمر الله و نهيه. في رواية الهرويّ عن ابن مسعود، و عن أبي حمزة الثماليّ عن أصحاب عليّ عنهعليهالسلام .
و في تفسير القمّيّ في قوله تعالى:( فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ) قال: يذهب نورها و تسقط.
و فيه، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرعليهالسلام في قوله:( فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ) فطمسها ذهاب ضوئها( وَ إِذَا السَّماءُ فُرِجَتْ ) قال: تفرج و تنشقّ( وَ إِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ ) قال: بعثت في أوقات مختلفة.
و في المجمع، قال الصادقعليهالسلام :( أُقِّتَتْ ) أي بعثت في أوقات مختلفة.
و في تفسير القمّيّ في قوله تعالى:( لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ) قال: اُخّرت.
( سورة المرسلات الآيات 16 - 50)
أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ( 16 ) ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ( 17 ) كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ( 18 ) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ( 19 ) أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ( 20 ) فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ( 21 ) إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ( 22 ) فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ( 23 ) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ( 24 ) أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ( 25 ) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ( 26 ) وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا ( 27 ) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ( 28 ) انطَلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ( 29 ) انطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ( 30 ) لَّا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللهَبِ ( 31 ) إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ( 32 ) كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ ( 33 ) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ( 34 ) هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ( 35 ) وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ( 36 ) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ( 37 ) هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ( 38 ) فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ( 39 ) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ( 40 ) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ ( 41 ) وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ( 42 ) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ( 43 ) إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ( 44 ) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ( 45 ) كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا
إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ ( 46 ) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ( 47 ) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ( 48 ) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ( 49 ) فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ( 50 )
( بيان)
حجج دالّة على توحّد الربوبيّة تقضي بوجود يوم الفصل الّذي فيه جزاء المكذّبين به، و إشارة إلى ما فيه من الجزاء المعدّ لهم الّذي كانوا يكذّبون به، و إلى ما فيه من النعمة و الكرامة للمتّقين، و تختتم بتوبيخهم و ذمّهم على استكبارهم عن عبادته تعالى و الإيمان بكلامه.
قوله تعالى: ( أَ لَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ) الاستفهام للإنكار، و المراد بالأوّلين أمثال قوم نوح و عاد و ثمود من الاُمم القديمة عهداً، و بالآخرين الملحقون بهم من الاُمم الغابرة، و الإتباع جعل الشيء أثر الشيء.
و قوله:( ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ) برفع نتبع على الاستيناف و ليس بمعطوف على( نُهْلِكِ ) و إلّا لجزم.
و المعنى قد أهلكنا المكذّبين من الاُمم الأوّلين ثمّ إنّا نهلك الاُمم الآخرين على أثرهم.
و قوله:( كَذلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ) في موضع التعليل لما تقدّمه و لذا اُورد بالفصل من غير عطف كأنّ قائلاً قال: لما ذا اُهلكوا؟ فقيل: كذلك نفعل بالمجرمين. و الآيات - كما ترى - إنذار و إرجاع للبيان إلى الأصل المضروب في السورة أعني قوله:( وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ) و هي بعينها حجّة على توحّد الربوبيّة فإنّ إهلاك المجرمين من الإنسان تصرّف في العالم الإنسانيّ و تدبير، و إذ ليس المهلك إلّا الله - و قد اعترف به المشركون - فهو الرّبّ لا ربّ سواه و لا إله غيره.
على أنّها تدلّ على وجود يوم الفصل لأنّ إهلاك قوم لإجرامهم لا يتمّ إلّا بعد توجّه تكليف إليهم يعصونه و لا معنى للتكليف إلّا مع مجازاة المطيع بالثواب و العاصي بالعقاب فهناك يوم يفصل فيه القضاء فيثاب فيه المطيع و يعاقب فيه العاصي و ليس هو الثواب و العقاب الدنيويين لأنّهما لا يستوعبان في هذه الدار فهناك يوم يجازى فيه كلّ بما عمل، و هو يوم الفصل ذلك يوم مجموع له الناس.
قوله تعالى: ( أَ لَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ - إلى قوله -فَنِعْمَ الْقادِرُونَ ) الاستفهام للإنكار و الماء المهين الحقير قليل الغناء و المراد به النطفة، و المراد بالقرار المكين الرحم و بقوله:( قَدَرٍ مَعْلُومٍ ) مدّة الحمل.
و قوله:( فَقَدَرْنا ) من القدر بمعنى التقدير، و الفاء لتفريع القدر على الخلق أي خلقناكم فقدرنا ما سيجري عليكم من الحوادث و ما يستقبلكم من الأوصاف و الأحوال من طول العمر و قصره و هيئة و جمال و صحّة و مرض و رزق إلى غير ذلك.
و احتمل أن يكون( فَقَدَرْنا ) من القدرة مقابل العجز و المراد فقدرنا على جميع ذلك، و ما تقدّم أوجه.
و المعنى: قد خلقناكم من ماء حقير هو النطفة فجعلنا ذلك الماء في قرار مكين هي الرحم إلى مدّة معلومة هي مدّة الحمل فقدّرنا جميع ما يتعلّق بوجودكم من الحوادث و الصفات و الأحوال فنعم المقدّرون نحن.
و يجري في كون مضمون هذه الآيات حجّة على توحّد الربوبيّة نظير البيان السابق في الآيات المتقدّمة، و كذا في كونه حجّة على تحقّق يوم الفصل فإنّ الربوبيّة تستوجب خضوع المربوبين لساحتها و هو الدين المتضمّن للتكليف، و لا يتمّ التكليف إلّا بجعل جزاء على الطاعة و العصيان، و اليوم الّذي يجازى فيه بالأعمال هو يوم الفصل.
قوله تعالى: ( أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفاتاً أَحْياءً وَ أَمْواتاً - إلى قوله -فُراتاً ) الكفت و الكفات بمعنى الضمّ و الجمع أي أ لم نجعل الأرض كفاتاً يجمع العباد أحياء
و أمواتاً، و قيل: الكفات جمع كفت بمعنى الوعاء، و المعنى أ لم نجعل الأرض أوعية تجمع الأحياء و الأموات.
و قوله:( وَ جَعَلْنا فِيها رَواسِيَ شامِخاتٍ ) الرواسي الثابتات من الجبال، و الشامخات العاليات، و كأنّ في ذكر الرواسي توطئة لقوله:( وَ أَسْقَيْناكُمْ ماءً فُراتاً ) لأنّ الأنهار و العيون الطبيعية تنفجر من الجبال فتجري على السهول، و الفرات الماء العذب.
و يجري في حجّيّة الآيات نظير البيان السابق في الآيات المتقدّمة.
قوله تعالى: ( انْطَلِقُوا إِلى ما كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ) حكاية لما يقال لهم يوم الفصل و القائل هو الله سبحانه بقرينة قوله في آخر الآيات:( فَإِنْ كانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ) و المراد بما كانوا به يكذّبون: جهنّم، و الانطلاق الانتقال من مكان إلى مكان من غير مكث، و المعنى يقال لهم: انتقلوا من المحشر من غير مكث إلى النار الّتي كنتم تكذّبون به.
قوله تعالى: ( انْطَلِقُوا إِلى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ ) ذكروا أنّ المراد بهذا الظلّ ظلّ دخان نار جهنّم قال تعالى:( وَ ظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ ) الواقعة: 43.
و ذكروا أنّ في ذكر انشعابه إلى ثلاث شعب إشارة إلى عظم الدخان فإنّ الدخان العظيم يتفرّق تفرّق الذوائب.
قوله تعالى: ( لا ظَلِيلٍ وَ لا يُغْنِي مِنَ اللهَبِ ) الظلّ الظليل هو المانع من الحرّ و الأذى بستره على المستظلّ فكون الظلّ غير ظليل كونه لا يمنع ذلك، و اللهب ما يعلو على النار من أحمر و أصفر و أخضر.
قوله تعالى: ( إِنَّها تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمالَتٌ صُفْرٌ ) ضمير( إِنَّها ) للنار المعلومة من السياق، و الشرر ما يتطاير من النار، و القصر معروف، و الجمالة جمع جمل و هو البعير. و المعنى ظاهر.
قوله تعالى: ( هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ وَ لا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ) الإشارة إلى يوم الفصل، و المراد بالإذن الإذن في النطق أو في الاعتذار.
و قوله:( فَيَعْتَذِرُونَ ) معطوف على( يُؤْذَنُ ) منتظم معه في سلك النفي، و المعنى هذا اليوم يوم لا ينطقون فيه أي أهل المحشر من الناس و لا يؤذن لهم في النطق أو في الاعتذار فلا يعتذرون، و لا ينافي نفي النطق ههنا إثباته في آيات اُخر لأنّ اليوم ذو مواقف كثيرة مختلفة يسألون في بعضها فينطقون و يختم على أفواههم في آخر فلا ينطقون.
و قد تقدّم في تفسير قوله تعالى:( يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ) هود: 105 فليراجع.
قوله تعالى: ( هذا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْناكُمْ وَ الْأَوَّلِينَ فَإِنْ كانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ) سمّي يوم الفصل لما أنّ الله تعالى يفصل و يميّز فيه بين أهل الحقّ و أهل الباطل بالقضاء بينهم قال تعالى:( إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ) السجدة: 25، و قال:( إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ) يونس: 93.
و الخطاب في قوله:( جَمَعْناكُمْ وَ الْأَوَّلِينَ ) لمكذّبي هذه الاُمّة بما أنّهم من الآخرين و لذا قوبلوا بالأوّلين قال تعالى:( ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ ) هود: 103 و قال( وَ حَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً ) الكهف: 67.
و قوله:( فَإِنْ كانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ) أي إن كانت لكم حيلة تحتالون بي في دفع عذابي عن أنفسكم فاحتالوا، و هذا خطاب تعجيزيّ منبئ عن انسلاب القوّة و القدرة عنهم يومئذ بالكلّيّة بظهور أن لا قوّة إلّا لله عزّ اسمه قال تعالى:( وَ لَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَ أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعَذابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَ رَأَوُا الْعَذابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبابُ ) البقرة: 166.
و الآية أعني قوله:( فَإِنْ كانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ) أوسع مدلولاً من قوله:( يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ فَانْفُذُوا
لا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطانٍ ) الرحمن: 33 لاختصاصه بنفي القدرة على الفرار بخلاف الآية الّتي نحن فيها.
و في قوله:( فَكِيدُونِ ) التفات من التكلّم مع الغير إلى التكلّم وحده و النكتة فيه أنّ متعلّق هذا الأمر التعجيزيّ إنّما هو الكيد لمن له القوّة و القدرة فحسب و هو الله وحده و لو قيل: فكيدونا فأت الإشعار بالتوحّد.
قوله تعالى: ( إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلالٍ وَ عُيُونٍ وَ فَواكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ - إلى قوله -الْمُحْسِنِينَ ) الظلال و العيون ظلال الجنّة و عيونها الّتي يتنعّمون بالاستظلال بها و شربها، و الفواكه جمع فاكهة و هي الثمرة.
و قوله:( كُلُوا وَ اشْرَبُوا هَنِيئاً بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) مفاده الإذن و الإباحة، و كان الأكل و الشرب كناية عن مطلق التنعّم بنعم الجنّة و التصرّف فيها و إن لم يكن بالأكل و الشرب، و هو شائع كما يطلق أكل المال على مطلق التصرّف فيه.
و قوله:( إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ) تسجيل لسعادتهم.
قوله تعالى: ( كُلُوا وَ تَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ) الخطاب من قبيل قولهم: افعل ما شئت فإنّه لا ينفعك، و هذا النوع من الأمر إياس للمخاطب أن ينتفع بما يأتي به من الفعل للحصول على ما يريده، و منه قوله:( فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ إِنَّما تَقْضِي هذِهِ الْحَياةَ الدُّنْيا ) طه: 72، و قوله:( اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) حم السجدة: 40.
فقوله:( كُلُوا وَ تَمَتَّعُوا قَلِيلًا ) أي تمتّعاً قليلاً أو زماناً قليلاً إياس لهم من أن ينتفعوا بمثل الأكل و التمتّع في دفع العذاب عن أنفسهم فليأكلوا و ليتمتّعوا قليلاً فليس يدفع عنهم شيئاً.
و إنّما ذكر الأكل و التمتّع لأنّ منكري المعاد لا يرون من السعادة إلّا سعادة الحياة الدنيا و لا يرون لها من السعادة إلّا الفوز بالأكل و التمتّع كالحيوان العجم قال
تعالى:( وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَ يَأْكُلُونَ كَما تَأْكُلُ الْأَنْعامُ وَ النَّارُ مَثْوىً لَهُمْ ) سورة محمّد: 12.
و قوله:( إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ) تعليل لما يستفاد من الجملة السابقة المشتملة على الأمر أي لا ينفعكم الأكل و التمتّع قليلاً لأنّكم مجرمون بتكذيبكم بيوم الفصل و جزاء المكذّبين به النار لا محالة.
قوله تعالى: ( وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ ) المراد بالركوع الصلاة كما قيل و لعلّ ذلك باعتبار اشتمالها على الركوع.
و قيل: المراد بالركوع المأمور به الخشوع و الخضوع و التواضع له تعالى باستجابة دعوته و قبول كلامه و اتّباع دينه، و عبادته.
و قيل: المراد بالركوع ما يؤمرون بالسجود يوم القيامة كما يشير إليه قوله تعالى( وَ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ ) القلم: 42 و الوجهان لا يخلوان من بُعد.
و وجه اتّصال الآية بما قبلها أنّ الكلام كان مسوقاً لتهديد المكذّبين بيوم الفصل و بيان تبعة تكذيبهم به و تمّم ذلك في هذه الآية بأنّهم لا يعبدون الله إذا دعوا إلى عبادته كما ينكرون ذلك اليوم فلا معنى للعبادة مع نفي الجزاء، و ليكون كالتوطئة لقوله الآتي:( فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ) .
و نسب إلى الزمخشريّ أنّ الآية متّصلة بقوله في الآية السابقة:( لِلْمُكَذِّبِينَ ) كأنّه قيل: ويل يومئذ للّذين كذّبوا و الّذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون.
و في الآية التفات من الخطاب إلى الغيبة في قوله:( وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ ) إلخ وجهه الإعراض عن مخاطبتهم بعد تركهم و أنفسهم يفعلون ما يشاؤن بقوله:( كُلُوا وَ تَمَتَّعُوا ) .
قوله تعالى: ( فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ) أي إذا لم يؤمنوا بالقرآن و هو آية معجزة إلهيّة، و قد بيّن لهم أنّ الله لا إله إلّا هو وحده لا شريك له و أنّ أمامهم يوم الفصل بأوضح البيان و ساطع البرهان فبأيّ كلام بعد القرآن يؤمنون.
و هذا إيئاس من إيمانهم بالله و رسوله و اليوم الآخر و كالتنبيه على أنّ رفع اليد عن دعوتهم إلى الإيمان بإلقاء قوله:( كُلُوا وَ تَمَتَّعُوا ) إليهم في محلّه فليسوا بمؤمنين و لا فائدة في دعوتهم غير أنّ فيها إتماماً للحجّة.
( بحث روائي)
في تفسير القمّيّ و قوله:( أَ لَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ ) قال: منتن( فَجَعَلْناهُ فِي قَرارٍ مَكِينٍ ) قال: في الرحم و أمّا قوله:( إِلى قَدَرٍ مَعْلُومٍ ) يقول: منتهى الأجل.
أقول: و في اُصول الكافي، في رواية عن أبي الحسن الماضيعليهالسلام : تطبيق قوله:( أَ لَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ) على مكذّبي الرسل في طاعة الأوصياء، و قوله:( ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ) على من أجرم إلى آل محمّدعليهمالسلام . على اضطراب في متن الخبر، و هو من الجري دون التفسير.
و فيه: و قوله( أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفاتاً أَحْياءً وَ أَمْواتاً ) قال الكفات المساكن و قال: نظر أميرالمؤمنينعليهالسلام في رجوعه من صفّين إلى المقابر فقال: هذه كفات الأموات أي مساكنهم ثمّ نظر إلى بيوت الكوفة فقال: هذه كفات الأحياء. ثمّ تلا قوله:( أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفاتاً أَحْياءً وَ أَمْواتاً ) .
أقول: و روي في المعاني، بإسناده عن حمّاد عن أبي عبداللهعليهالسلام أنّه نظر إلى المقابر. و ذكر مثل الحديث السابق.
و فيه: و قوله( وَ جَعَلْنا فِيها رَواسِيَ شامِخاتٍ ) قال: جبال مرتفعة.
و فيه: و قوله( انْطَلِقُوا إِلى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ ) قال فيه ثلاث شعب من النار و قوله:( إِنَّها تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ) قال: شرر النار مثل القصور و الجبال.
و فيه: و قوله( إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلالٍ وَ عُيُونٍ ) قال: في ظلال من نور أنور من الشمس.
و في المجمع: في قوله:( وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ ) قال مقاتل: نزلت في ثقيف حين أمرهم رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم بالصلاة فقالوا: لا ننحني. و الرواية لا نحني فإنّ ذلك سبّة علينا. فقالصلىاللهعليهوآلهوسلم : لا خير في دين ليس فيه ركوع و سجود.
أقول: و في انطباق القصّة - و قد وقعت بعد الهجرة - على الآية خفاء.
و في تفسير القمّيّ في الآية السابقة قال: و إذا قيل لهم( تولّوا الإمام لم يتولّوه) .
أقول: و هو من الجري دون التفسير.
( سورة النبإ مكّيّة و هي أربعون آية)
( سورة النبإ الآيات 1 - 16)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ( 1 ) عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ ( 2 ) الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ( 3 ) كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ( 4 ) ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ( 5 ) أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ( 6 ) وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ( 7 ) وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ( 8 ) وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ( 9 ) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ( 10 ) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ( 11 ) وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ( 12 ) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ( 13 ) وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ( 14 ) لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ( 15 ) وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ( 16 )
( بيان)
تتضمّن السورة الإخبار بمجيء يوم الفصل و صفته و الاحتجاج على أنّه حقّ لا ريب فيه، فقد افتتحت بذكر تساؤلهم عن نبإه ثمّ ذكر في سياق الجواب و لحن التهديد أنّهم سيعلمون ثمّ احتجّ على ثبوته بالإشارة إلى النظام المشهود في الكون بما فيه من التدبير الحكيم الدالّ بأوضح الدلالة على أنّ وراء هذه النشأة المتغيّرة الدائرة نشأة ثابتة باقية، و أنّ عقيب هذه الدار الّتي فيها عمل و لا جزاء داراً فيها جزاء و لا عمل فهناك يوم يفصح عنه هذا النظام.
ثمّ تصف اليوم بما يقع فيه من إحضار الناس و حضورهم و انقلاب الطاغين إلى عذاب أليم و المتّقين إلى نعيم مقيم و يختم الكلام بكلمة في الإنذار، و السورة مكّيّة بشهادة سياق آياتها.
قوله تعالى: ( عَمَّ يَتَساءَلُونَ ) ( عَمَّ ) أصله عمّا و ما استفهاميّة تحذف الألف منها اطّراداً إذا دخل عليها حرف الجرّ نحو لم و ممّ و على م و إلى م، و التساؤل سؤال القوم بعضهم بعضاً عن أمر أو سؤال بعضهم بعد بعض عن أمر و إن كان المسؤل غيرهم، فهم كان يسأل بعضهم بعضاً عن أمر أو كان بعضهم بعد بعض يسأل النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم عن أمر و حيث كان سياق السورة سياق جواب يغلب فيه الإنذار و الوعيد تأيّد به أنّ المتسائلين هم كفّار مكّة من المشركين النافين للنبوّة و المعاد دون المؤمنين و دون الكفّار و المؤمنين جميعاً.
فالتساؤل من المشركين و الإخبار عنه في صورة الاستفهام للإشعار بهوانه و حقارته لظهور الجواب عنه ظهوراً ما كان ينبغي معه أن يتساءلوا عنه.
قوله تعالى: ( عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ) جواب عن الاستفهام السابق أي يتساءلون عن النبإ العظيم، و لا يخفى ما في توصيف النبإ المتسائل عنه بالعظيم من تعظيمه و تفخيم أمره.
و المراد بالنبإ العظيم نبؤ البعث و القيامة الّذي يهتمّ به القرآن العظيم في سورة المكّيّة و لا سيّما في العتائق النازلة في أوائل البعثة كلّ الاهتمام.
و يؤيّد ذلك سياق آيات السورة بما فيه من الاقتصار على ذكر صفة يوم الفصل و ما تقدّم عليها من الحجّة على أنّه حقّ واقع.
و قيل: المراد به نبؤ القرآن العظيم، و يدفعه كون السياق بحسب مصبّه أجنبيّاً عنه و إن كان الكلام لا يخلو من إشارة إليه استلزاما.
و قيل: النبؤ العظيم ما كانوا يختلفون فيه من إثبات الصانع و صفاته و الملائكة و الرسل و البعث و الجنّة و النار و غيرها، و كأنّ القائل به اعتبر فيه ما في السورة من الإشارة إلى حقّيّة جميع ذلك ممّا تتضمّنه الدعوة الحقّة الإسلاميّة.
و يدفعه أنّ الإشارة إلى ذلك كلّه من لوازم صفة البعث المتضمّنة لجزاء الاعتقاد الحقّ و العمل الصالح و الكفر و الاجرام، و قد دخل فيما في السورة من صفة يوم الفصل تبعاً و بالقصد الثاني.
على أنّ المراد بهؤلاء المتسائلين - كما تقدّم - المشركون و هم يثبتون الصانع و الملائكة و ينفون ما وراء ذلك ممّا ذكر.
و قوله:( الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ) إنّما اختلفوا في نحو إنكاره و هم متّفقون في نفيه فمنهم من كان يرى استحالته فينكره كما هو ظاهر قولهم على ما حكاه الله:( هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ) سبأ: 7، و منهم من كان يستبعده فينكره و هو قولهم:( أَ يَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذا مِتُّمْ وَ كُنْتُمْ تُراباً وَ عِظاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهاتَ هَيْهاتَ لِما تُوعَدُونَ ) المؤمنون: 36، و منهم من كان يشكّ فيه فينكره قال تعالى:( بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْها ) النمل 66، و منهم من كان يوقن به لكنّه لا يؤمن عناداً فينكره كما كان لا يؤمن بالتوحيد و النبوّة و سائر فروع الدين بعد تمام الحجّة عناداً قال تعالى:( بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَ نُفُورٍ ) الملك: 21.
و المحصّل من سياق الآيات الثلاث و ما يتلوها أنّهم لما سمعوا ما ينذرهم به القرآن من أمر البعث و الجزاء يوم الفصل ثقل عليهم ذلك فغدوا يسأل بعضهم بعضاً عن شأن هذا النبإ العجيب الّذي لم يكن ممّا قرع أسماعهم حتّى اليوم، و ربّما راجعوا النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم و المؤمنين و سألوهم عن صفة اليوم و أنّه متى هذا الوعد إن كنتم صادقين و ربّما كانوا يراجعون في بعض ما قرع سمعهم من حقائق القرآن و احتوته دعوته الجديدة أهل الكتاب و خاصّة اليهود و يستمدّونهم في فهمه.
و قد أشار تعالى في هذه السورة إلى قصّة تساؤلهم في صورة السؤال و الجواب فقال:( عَمَّ يَتَساءَلُونَ ) و هو سؤال عمّا يتساءلون عنه. ثمّ قال:( عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ) و هو جواب السؤال عمّا يتساءلون عنه. ثمّ قال:( كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ) إلخ، و هو جواب عن تساؤلهم.
و للمفسّرين في مفردات الآيات الثلاث و تقرير معانيها وجوه كثيرة تركناها لعدم ملاءمتها السياق و الّذي أوردناه هو الّذي يعطيه السياق.
قوله تعالى: ( كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ) ردع عن تساؤلهم عنه بانين
ذلك على الاختلاف في النفي أي ليرتدعوا عن التساؤل لأنّه سينكشف لهم الأمر بوقوع هذا النبإ فيعلمونه، و في هذا التعبير تهديد كما في قوله:( وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ) الشعراء: 227.
و قوله:( ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ) تأكيد للردع و التهديد السابقين و لحن التهديد هو القرينة على أنّ المتسائلين هم المشركون النافون للبعث و الجزاء دون المؤمنين و دون المشركين و المؤمنين جميعاً.
قوله تعالى: ( أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهاداً ) الآية إلى تمام إحدى عشرة آية مسوق سوق الاحتجاج على ثبوت البعث و الجزاء و تحقّق هذا النبإ العظيم و لازم ثبوته صحّة ما في قوله:( سَيَعْلَمُونَ ) من الإخبار بأنّهم سيشاهدونه فيعلمون.
تقرير الحجّة: أنّ العالم المشهود بأرضه و سمائه و ليله و نهاره و البشر المتناسلين و النظام الجاري فيها و التدبير المتقن الدقيق لاُمورها من المحال أن يكون لعباً باطلاً لا غاية لها ثابتة باقية فمن الضروريّ أن يستعقب هذا النظام المتحوّل المتغيّر الدائر إلى عالم ذي نظام ثابت باق، و أن يظهر فيه أثر الصلاح الّذي تدعو إليه الفطرة الإنسانيّة و الفساد الّذي ترتدع عنه، و لم يظهر في هذا العالم المشهود أعني سعادة المتّقين و شقاء المفسدين، و من المحال أن يودع الله الفطرة دعوة غريزيّة أو ردعاً غريزيّاً بالنسبة إلى ما لا أثر له في الخارج و لا حظّ له من الوقوع فهناك يوم يلقاه الإنسان و يجزي فيه على عمله إن خيراً فخيراً و إن شرّاً فشرّاً.
فالآيات في معنى قوله تعالى( وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِلًا ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ) ص: 28.
و بهذا البيان يثبت أنّ هناك يوماً يلقاه الإنسان و يجزي فيه بما عمل إن خيراً فخيراً و إن شرّاً فشرّاً فليس للمشركين أن يختلفوا فيه فيشكّ فيه بعضهم و يستبعده طائفة، و يحيله قوم، و لا يؤمن به مع العلم به عناداً آخرون، فاليوم ضروري الوقوع
و الجزاء لا ريب فيه.
و يظهر من بعضهم أنّ الآيات مسوقة لإثبات القدرة و أنّ العود يماثل البدء و القادر على الإبداء قادر على الإعادة، و هذه الحجّة و إن كانت تامّة و قد وقعت في كلامه تعالى لكنّها حجّة على الإمكان دون الوقوع و السياق فيما نحن فيه سياق الوقوع دون الإمكان فالأنسب في تقريرها ما تقدّم.
و كيف كان فقوله:( أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهاداً ) الاستفهام للإنكار، و المهاد الوطاء و القرار الّذي يتصرّف فيه، و يطلق على البساط الّذي يُجلس عليه و المعنى قد جعلنا الأرض قراراً لكم تستقرّون عليها و تتصرّفون فيها.
قوله تعالى: ( وَ الْجِبالَ أَوْتاداً ) الأوتاد جمع وتد و هو المسمار إلّا أنّه أغلظ منه كما في المجمع، و لعلّ عدّ الجبال أوتاداً مبنيّ على أنّ عمدة جبال الأرض من عمل البركانات بشقّ الأرض فتخرج منه موادّ أرضيّة مذابة تنتصب على فم الشقّة متراكمة كهيئة الوتد المنصوب على الأرض تسكن به فورة البركان الّذي تحته فيرتفع به ما في الأرض من الاضطراب و الميدان.
و عن بعضهم: أنّ المراد بجعل الجبال أوتاداً انتظام معاش أهل الأرض بما اُودع فيها من المنافع و لولاها لمادت الأرض بهم أي لما تهيّأت لانتفاعهم. و فيه أنّه صرف اللفظ عن ظاهره من غير ضرورة موجبة.
قوله تعالى: ( وَ خَلَقْناكُمْ أَزْواجاً ) أي زوجاً زوجاً من ذكر و اُنثى لتجري بينكم سنّة التناسل فيدوم بقاء النوع إلى ما شاء الله.
و قيل: المراد به الإشكال أي كلّ منكم شكل للآخر. و قيل: المراد به الأصناف أي أصنافاً مختلفة كالأبيض و الأسود و الأحمر و الأصفر إلى غير ذلك، و قيل: المراد به خلق كلّ منهم من منيّين منيّ الرجل و منيّ المرأة و هذه وجوه ضعيفة.
قيل: الالتفات في الآية من الغيبة إلى الخطاب للمبالغة في الإلزام و التبكيت.
قوله تعالى: ( وَ جَعَلْنا نَوْمَكُمْ سُباتاً ) السبات الراحة و الدعة فإنّ في المنام
سكوتاً و راحة للقوى الحيوانيّة البدنيّة ممّا اعتراها في اليقظة من التعب و الكلال بواسطة تصرّفات النفس فيها.
و قيل: السبات بمعنى القطع و في النوم قطع التصرّفات النفسانيّة في البدن، و هو قريب من سابقه.
و قيل: المراد بالسبات الموت، و قد عدّ سبحانه النوم من الموت حيث قال:( وَ هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ ) الأنعام: 60 و هو بعيد، و أمّا الآية فإنّه تعالى عدّ النوم توفّياً و لم يعدّه موتاً بل القرآن يصرّح بخلافه قال تعالى:( اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَ الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها ) الزمر: 42.
قوله تعالى: ( وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِباساً ) أي ساتراً يستر الأشياء بما فيه من الظلمة الساترة للمبصرات كما يستر اللباس البدن و هذا سبب إلهيّ يدعو إلى ترك التقلّب و الحركة و الميل إلى السكن و الدعة و الرجوع إلى الأهل و المنزل.
و عن بعضهم أنّ المراد بكون الليل لباساً كونه كاللباس للنهار يسهل إخراجه منه و هو كما ترى.
قوله تعالى: ( وَ جَعَلْنَا النَّهارَ مَعاشاً ) العيش هو الحياة - على ما ذكره الراغب - غير أنّ العيش يختصّ بحياة الحيوان فلا يقال: عيشه تعالى و عيش الملائكة و يقال حياته تعالى و حياة الملائكة، و المعاش مصدر ميميّ و اسم زمان و اسم مكان، و هو في الآية بأحد المعنيين الأخيرين، و المعنى و جعلنا النهار زماناً لحياتكم أو موضعاً لحياتكم تبتغون فيه من فضل ربّكم، و قيل: المراد به المعنى المصدريّ بحذف مضاف، و التقدير و جعلنا النهار طلب معاش أي مبتغي معاش.
قوله تعالى: ( وَ بَنَيْنا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِداداً ) أي سبع سماوات شديدة في بنائها.
قوله تعالى: ( وَ جَعَلْنا سِراجاً وَهَّاجاً ) الوهّاج شديد النور و الحرارة و المراد بالسراج الوهّاج الشمس.
قوله تعالى: ( وَ أَنْزَلْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجَّاجاً ) المعصرات السحب الماطرة و قيل: الرياح الّتي تعصر السحب لتمطر و الثجّاج الكثير الصبّ للماء، و الأولى على هذا المعنى أن تكون( مِنَ ) بمعنى الباء.
قوله تعالى: ( لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَ نَباتاً ) أي حبّاً و نباتاً يقتات بهما الإنسان و سائر الحيوان.
قوله تعالى: ( وَ جَنَّاتٍ أَلْفافاً ) معطوف على قوله:( حَبًّا ) و جنّات ألفاف أي ملتفّة أشجارها بعضها ببعض.
قيل: إنّ الألفاف جمع لا واحد له من لفظه.
( بحث روائي)
في بعض الأخبار: أنّ النبأ العظيم عليّعليهالسلام و هو من البطن.
عن الخصال، عن عكرمة عن ابن عبّاس قال: قال أبوبكر: يا رسول الله أسرع إليك الشيب. قال: شيّبتني هود و الواقعة و المرسلات و عمّ يتساءلون.
في تفسير القمّيّ في قوله تعالى:( أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهاداً ) قال: يمهّد فيها الإنسان( وَ الْجِبالَ أَوْتاداً ) أي أوتاد الأرض.
و في نهج البلاغة، قالعليهالسلام : و وتّد بالصخور ميدان أرضه.
و في تفسير القمّيّ في قوله تعالى:( وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِباساً ) قال: يلبس على النهار.
أقول: و لعلّ المراد به أنّه يخفي ما يظهره النهار و يستر ما يكشفه.
و فيه: في قوله تعالى:( وَ جَعَلْنا سِراجاً وَهَّاجاً ) قال: الشمس المضيئة( وَ أَنْزَلْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ ) قال: من السحاب( ماءً ثَجَّاجاً ) قال: صبّاً على صبّ.
و عن تفسير العيّاشيّ، عن أبي عبداللهعليهالسلام :( عامٌ فِيهِ يُغاثُ النَّاسُ وَ فِيهِ يَعْصِرُونَ ) بالياء يمطرون.
ثمّ قال: أ ما سمعت قوله:( وَ أَنْزَلْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجَّاجاً ) .
أقول: المراد أنّ( يَعْصِرُونَ ) بضمّ الياء بصيغة المجهول و المراد به أنّهم يمطرون و استشهادهعليهالسلام بقوله:( وَ أَنْزَلْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ ) دليل على أنّهعليهالسلام أخذ المعصرات بمعنى الممطرات من أعصرت السحابة إذا أمطرت.
و روى العيّاشيّ مثل الحديث عن عليّ بن معمر عن أبيه عن أبي عبداللهعليهالسلام و روى القمّيّ في تفسيره،: مثله عن أميرالمؤمنين.
( سورة النبإ الآيات 17 - 40)
إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ( 17 ) يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ( 18 ) وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ( 19 ) وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ( 20 ) إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ( 21 ) لِّلطَّاغِينَ مَآبًا ( 22 ) لَّابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ( 23 ) لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ( 24 ) إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ( 25 ) جَزَاءً وِفَاقًا ( 26 ) إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ( 27 ) وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ( 28 ) وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ( 29 ) فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ( 30 ) إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ( 31 ) حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ( 32 ) وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ( 33 ) وَكَأْسًا دِهَاقًا ( 34 ) لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا ( 35 ) جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ( 36 ) رَّبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ( 37 ) يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ( 38 ) ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا ( 39 ) إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا ( 40 )
( بيان)
تصف الآيات يوم الفصل الّذي أخبر به إجمالاً بقوله:( كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ) ثمّ تصف ما يجري فيه على الطاغين و المتّقين، و تختتم بكلمة في الإنذار و هي كالنتيجة.
قوله تعالى: ( إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كانَ مِيقاتاً ) قال في المجمع: الميقات منتهى المقدار المضروب لحدوث أمر من الاُمور و هو من الوقت كما أنّ الميعاد من الوعد و المقدار من القدر، انتهى.
شروع في وصف ما تضمّنه النبأ العظيم الّذي أخبر بوقوعه و هدّدهم به في قوله:( كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ) ثمّ أقام الحجّة عليه بقوله:( أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهاداً ) إلخ، و قد سمّاه يوم الفصل و نبّه به على أنّه يوم يفصل فيه القضاء بين الناس فينال كلّ طائفة ما يستحقّه بعمله فهو ميقات و حدّ مضروب لفصل القضاء بينهم و التعبير بلفظ( كانَ ) للدلالة على ثبوته و تعيّنه في العلم الإلهيّ على ما ينطق به الحجّة السابقة الذكر، و لذا أكّد الجملة بإنّ.
و المعنى: إنّ يوم فصل القضاء الّذي نبؤه نبأ عظيم كان في علم الله يوم خلق السماوات و الأرض و حكّم فيها النظام الجاري حدّاً مضروباً ينتهي إليه هذا العالم فإنّه تعالى كان يعلم أنّ هذه النشأة الّتي أنشأها لا تتمّ إلّا بالانتهاء إلى يوم يفصل فيه القضاء بينهم.
قوله تعالى: ( يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً ) قد تقدّم الكلام في معنى نفخ الصور كراراً، و الأفواج جمع فوج و هي الجماعة المارّة المسرعة على ما ذكره الراغب.
و في قوله:( فَتَأْتُونَ أَفْواجاً ) جري على الخطاب السابق الملتفت إليه قضاءً لحقّ الوعيد الّذي يتضمّنه قوله:( كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ) و كأنّ الآية ناظرة إلى قوله تعالى:( يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ ) إسراء: 71.
قوله تعالى: ( وَ فُتِحَتِ السَّماءُ فَكانَتْ أَبْواباً ) فاتّصل به عالم الإنسان بعالم الملائكة.
و قيل: التقدير فكانت ذات أبواب، و قيل: صار فيها طرق و لم يكن كذلك من قبل، و لا يخلو الوجهان من تحكّم فليتدبّر.
قوله تعالى: ( وَ سُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سَراباً ) السراب هو الموهوم من الماء اللّامع في المفاوز و يطلق على كلّ ما يتوهّم ذا حقيقة و لا حقيقة له على طريق الاستعارة.
و لعلّ المراد بالسراب في الآية هو المعنى الثاني.
بيان ذلك: أنّ تسيير الجبال و دكّها ينتهي بالطبع إلى تفرّق أجزائها و زوال شكلها كما وقع في مواضع من كلامه تعالى عند وصف زلزلة الساعة و آثارها إذ قال:( وَ تَسِيرُ الْجِبالُ سَيْراً ) الطور: 10 و قال:( وَ حُمِلَتِ الْأَرْضُ وَ الْجِبالُ فَدُكَّتا دَكَّةً واحِدَةً ) الحاقّة: 14، و قال:( وَ كانَتِ الْجِبالُ كَثِيباً مَهِيلًا ) المزّمّل: 14، و قال:( وَ تَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ) القارعة: 5، و قال:( وَ بُسَّتِ الْجِبالُ بَسًّا ) الواقعة: 5، و قال:( وَ إِذَا الْجِبالُ نُسِفَتْ ) المرسلات: 10.
فتسيير الجبال و دكّها ينتهي بها إلى بسّها و نسفها و صيرورتها كثيباً مهيلاً و كالعهن المنفوش كما ذكره الله تعالى و أمّا صيرورتها سراباً بمعنى ما يتوهّم ماءً لامعاً فلا نسبة بين التسيير و بين السراب بهذا المعنى.
نعم ينتهي تسييرها إلى انعدامها و بطلان كينونتها و حقيقتها بمعنى كونها جبلاً فالجبال الراسيات الّتي كانت ترى حقائق ذوات كينونة قويّة لا تحرّكه العواصف تتبدّل بالتسيير سراباً باطلاً لا حقيقة له، و نظيره من كلامه تعالى قوله في أقوام أهلكهم و قطع دابرهم،( فَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ ) سبأ: 19 و قوله:( فَأَتْبَعْنا بَعْضَهُمْ بَعْضاً وَ جَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ ) المؤمنون: 44، و قوله في الأصنام( إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ ) النجم: 23.
فالآية بوجه كقوله تعالى:( وَ تَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ ) النمل: 88 - بناء على كونه ناظراً إلى صفة زلزلة الساعة -.
قوله تعالى: ( إِنَّ جَهَنَّمَ كانَتْ مِرْصاداً ) قال في المفردات: الرصد الاستعداد للترقّب - إلى أن قال - و المرصد موضع الرصد قال تعالى:( وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ) و المرصاد نحوه لكن يقال للمكان الّذي اختصّ بالرصد قال تعالى:( إِنَّ جَهَنَّمَ كانَتْ مِرْصاداً ) تنبيهاً على أنّ عليها مجاز الناس، و على هذا قوله تعالى:( وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها ) انتهى.
قوله تعالى: ( لِلطَّاغِينَ مَآباً ) الطاغون الملتبّسون بالطغيان و هو الخروج عن الحدّ، و المآب اسم مكان من الأوب بمعنى الرجوع، و العناية في عدّها مآباً للطاغين أنّهم هيّئوها مأوى لأنفسهم و هم في الدنيا ثمّ إذا انقطعوا عن الدنيا آبوا و رجعوا إليها.
قوله تعالى: ( لابِثِينَ فِيها أَحْقاباً ) الأحقاب الأزمنة الكثيرة و الدهور الطويلة من غير تحديد.
و هو جمع اختلفوا في واحده فقيل: واحده حقب بالضمّ فالسكون أو بضمّتين، و قد وقع في قوله تعالى:( أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً ) الكهف: 60، و قيل: حقب بالفتح فالسكون و واحد الحقب حقبة بالكسر فالسكون قال الراغب: و الحقّ أنّ الحقبة مدّة من الزمان مبهمة. انتهى.
و حدّ بعضهم الحقب بثمانين سنة أو ببضع و ثمانين سنة و زاد آخرون أنّ السنة منها ثلاثمائة و ستّون يوماً كلّ يوم يعدل ألف سنة، و عن بعضهم أنّ الحقب أربعون سنة و عن آخرين أنّه سبعون ألف سنة إلى غير ذلك و لا دليل من الكتاب يدلّ على شيء من هذه التحديدات و لم يثبت من اللغة شيء منها.
و ظاهر الآية أنّ المراد بالطاغين المعاندون من الكفّار و يؤيّده قوله ذيلاً:( إِنَّهُمْ كانُوا لا يَرْجُونَ حِساباً وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا كِذَّاباً ) .
و قد فسّروا( أَحْقاباً ) في الآية بالحقب بعد الحقب فالمعنى حال كون الطاغين
لابثين في جهنّم حقباً بعد حقب بلا تحديد و لا نهاية فلا تنافي الآية ما نصّ عليه القرآن من خلود الكفّار في النار.
و قيل: إنّ قوله:( لا يَذُوقُونَ فِيها ) إلخ صفة( أَحْقاباً ) و المعنى لابثين فيها أحقاباً هي على هذه الصفة و هي أنّهم لا يذوقون فيها برداً و لا شراباً إلّا حميماً و غسّاقاً، ثمّ يكونون على غير هذه الصفة إلى غير النهاية.
و هو حسن لو ساعد السياق.
قوله تعالى: ( لا يَذُوقُونَ فِيها بَرْداً وَ لا شَراباً ) ظاهر المقابلة بين البرد و الشراب أنّ المراد بالبرد مطلق ما يتبرّد به غير الشراب كالظلّ الّذي يستراح إليه بالاستظلال فالمراد بالذّوق مطلق النيل و المسّ.
قوله تعالى: ( إِلَّا حَمِيماً وَ غَسَّاقاً ) الحميم الماء الحارّ شديد الحرّ، و الغسّاق صديد أهل النار.
قوله تعالى: ( جَزاءً وِفاقاً - إلى قوله -كِتاباً ) المصدر بمعنى اسم الفاعل و المعنى يجزون جزاء موافقاً لما عملوا أو بتقدير مضاف أي جزاءً ذا وفاق أو إطلاق الوفاق على الجزاء للمبالغة كزيد عدل.
و قوله:( إِنَّهُمْ كانُوا لا يَرْجُونَ حِساباً وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا كِذَّاباً ) أي تكذيباً عجيباً يصرّون عليه، تعليل يوضح موافقة جزائهم لعملهم، و ذلك أنّهم لم يرجوا الحساب يوم الفصل فأيسوا من الحياة الآخرة و كذّبوا بالآيات الدالّة عليها فأنكروا التوحيد و النبوّة و تعدّوا في أعمالهم طور العبوديّة فنسوا الله تعالى فنسيهم و حرّم عليهم سعادة الدار الآخرة فلم يبق لهم إلّا الشقاء و لا يجدون فيها إلّا ما يكرهون، و لا يواجهون إلّا ما يتعذّبون به و هو قوله:( فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذاباً ) .
و في الآية أعني قوله:( جَزاءً وِفاقاً ) دلالة على المطابقة التامّة بين الجزاء و العمل فالإنسان لا يريد بعمله إلّا الجزاء الّذي بإزائه و التلبّس بالجزاء تلبّس بالعمل بالحقيقة قال تعالى:( يا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) التحريم: 7.
و قوله:( وَ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ كِتاباً ) أي كلّ شيء و منه الأعمال ضبطناه و بينّاه في كتاب جليل القدر فالآية في معنى قوله تعالى:( وَ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ ) يس: 13.
أو المراد و كلّ شيء حفظناه حال كونه مكتوباً أي في اللوح المحفوظ أو في صحائف الأعمال، و جوّز أن يكون الإحصاء بمعنى الكتابة أو الكتاب بمعنى الإحصاء فإنّ الإحصاء و الكتابة يتشاركان في معنى الضبط و المعنى كلّ شيء أحصيناه إحصاء أو كلّ شيء كتبناه كتاباً.
و الآية على أيّ حال متمّم للتعليل السابق، و المعنى الجزاء موافق لأعمالهم لأنّهم كانوا على حال كذا و كذا و قد حفظناها عليهم فجزيناهم بها جزاءً وفاقاً.
قوله تعالى: ( فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذاباً ) تفريع على ما تقدّم من تفصيل عذابهم مسوق لإيئاسهم من أن يرجو نجاة من الشقوة و راحة ينالونها.
و الالتفات إلى خطابهم بقوله:( فَذُوقُوا ) تقدير لحضورهم ليخاطبوا بالتوبيخ و التقريع بلا واسطة.
و المراد بقوله:( فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذاباً ) أنّ ما تذوقونه بعد عذاب ذقتموه عذاب آخر فهو عذاب بعد عذاب و عذاب على عذاب فلا تزالون يضاف عذاب جديد إلى عذابكم القديم فاقنطوا من أن تنالوا شيئاً ممّا تطلبون و تحبّون.
و الآية لا تخلو من ظهور في كون المراد بقوله:( لابِثِينَ فِيها أَحْقاباً ) الخلود دون الانقطاع.
قوله تعالى: ( إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفازاً - إلى قوله -كِذَّاباً ) الفوز الظفر بالخير مع حصول السلامة - على ما قاله الراغب - ففيه معنى النجاة و التخلّص من الشرّ و الحصول على الخير، و المفاز مصدر ميميّ أو اسم مكان من الفوز و الآية تحتمل الوجهين جميعاً.
و قوله:( حَدائِقَ وَ أَعْناباً ) الحدائق جمع حديقة و هي البستان المحوّط، و الأعناب جمع عنب و هو ثمر شجرة الكرم و ربّما يطلق على نفس الشجرة.
و قوله:( وَ كَواعِبَ ) جمع كاعب و هي الفتاة الّتي تكعّب ثدياها و استدار مع ارتفاع يسير، و الترائب جمع ترب و هي المماثلة لغيرها من اللذات.
و قوله:( وَ كَأْساً دِهاقاً ) أي ممتلئة شراباً مصدر بمعنى اسم الفاعل.
و قوله:( لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَ لا كِذَّاباً ) أي لا يسمعون في الجنّة لغواً من القول لا يترتّب عليه أثر مطلوب و لا تكذيباً من بعضهم لبعضهم فيما قال فقولهم حقّ له أثره المطلوب و صدق مطابق للواقع.
قوله تعالى: ( جَزاءً مِنْ رَبِّكَ عَطاءً حِساباً ) أي فعل بالمتّقين ما فعل حال كونه جزاء من ربّك عطيّة محسوبة فقوله:( جَزاءً ) حال و كذا( عَطاءً ) و( حِساباً ) بمعنى اسم المفعول صفة لعطاء، و يحتمل أن يكون عطاء تمييزاً أو مفعولاً مطلقاً.
قيل: إضافة الجزاء إلى الربّ مضافاً إلى ضميرهصلىاللهعليهوآلهوسلم تشريف له، و لم يضف جزاء الطاغين إليه تعالى تنزّهاً منه تعالى فليس يغشاهم شرّ إلّا من عند أنفسهم قال تعالى:( ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَ أَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ) الأنفال: 51.
و وقوع لفظ الحساب في ذيل جزاء الطاغين و المتّقين معاً لتثبيت ما يلوّح إليه يوم الفصل الواقع في أوّل الكلام.
قوله تعالى: ( رَبِّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُمَا الرَّحْمنِ ) بيان لقوله:( رَبِّكَ ) اُريد به أنّ ربوبيّته تعالى عامّة لكلّ شيء و أنّ الربّ الّذي يتّخذه النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم ربّاً و يدعو إليه ربّ كلّ شيء لا كما كان يقول المشركون: إنّ لكلّ طائفة من الموجودات ربّاً و الله سبحانه ربّ الأرباب أو كما كان يقول بعضهم: إنّه ربّ السماء.
و في توصيف الربّ بالرحمن - صيغة مبالغة من الرحمة - إشارة إلى سعة رحمته و أنّها سمة ربوبيّة لا يحرم منها شيء إلّا أن يمتنع منها شيء بنفسه لقصوره و سوء اختياره فمن شقوة هؤلاء الطاغين أنّهم حرّموها على أنفسهم بالخروج عن طور العبودية.
قوله تعالى: ( لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطاباً يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلائِكَةُ صَفًّا لا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ قالَ صَواباً ) وقوع صدر الآية في سياق قوله:
( رَبِّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُمَا الرَّحْمنِ ) - و شأن الربوبيّة هو التدبير و شأن الرحمانيّة بسط الرحمة - دليل على أنّ المراد بخطابه تعالى تكليمه في بعض ما فعل من الفعل بنحو السؤال عن السبب الداعي إلى الفعل كأن يقال: لم فعلت هذا؟ و لم لم تفعل كذا؟ كما يسأل الفاعل منّا عن فعله فتكون الجملة( لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطاباً ) في معنى قوله تعالى:( لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ ) الأنبياء: 23 و قد تقدّم الكلام في معنى الآية.
لكن وقوع قوله:( يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلائِكَةُ صَفًّا ) بعد قوله:( لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطاباً ) الظاهر في اختصاص عدم الملك بيوم الفصل مضافاً إلى وقوعه في سياق تفصيل جزاء الطاغين و المتّقين منه تعالى يوم الفصل يعطي أن يكون المراد به أنّهم لا يملكون أن يخاطبوه فيما يقضي و يفعل بهم باعتراض عليه أو شفاعة فيهم لكنّ الملائكة - و هم ممّن لا يملكون منه خطاباً - منزّهون عن وصمة الاعتراض عليه تعالى و قد قال فيهم:( عِبادٌ مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ) الأنبياء: 27 و كذلك الروح الّذي هو(1) كلمته و قوله، و قوله(2) حقّ، و هو تعالى (3) الحقّ المبين و الحقّ لا يعارض الحقّ و لا يناقضه.
و من هنا يظهر أنّ المراد بالخطاب الّذي لا يملكونه هو الشفاعة و ما يجري مجراها من وسائل التخلّص من الشرّ كالعدل و البيع و الخلّة و الدعاء و السؤال قال تعالى:( مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَ لا خُلَّةٌ وَ لا شَفاعَةٌ ) البقرة: 254، و قال:( وَ لا يُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا تَنْفَعُها شَفاعَةٌ ) البقرة: 123، و قال:( يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ) هود: 105.
و بالجملة قوله:( لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطاباً ) ضمير الفاعل في( لا يَمْلِكُونَ ) لجميع المجموعين ليوم الفصل من الملائكة و الروح و الإنس و الجنّ كما هو المناسب
____________________
(1) النحل: 40.
(2) الأنعام: 73.
(3) النور: 25.
للسياق الحاكي عن ظهور العظمة و الكبرياء دون خصوص الملائكة و الروح لعدم سبق الذكر و دون خصوص الطاغين كما قيل لكثرة الفصل، و المراد بالخطاب الشفاعة و ما يجري مجراها كما تقدّم.
و قوله:( يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلائِكَةُ صَفًّا ) ظرف لقوله:( لا يَمْلِكُونَ ) و قيل: لقوله:( لا يَتَكَلَّمُونَ ) و هو بعيد مع صلاحية ظرفيّته لما سبقه.
و المراد بالروح المخلوق الأمريّ الّذي يشير إليه قوله تعالى:( قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ) إسراء: 85.
و قيل: المراد به أشراف الملائكة، و قيل حفظة الملائكة و قيل: ملك موكّل على الأرواح. و لا دليل على شيء من هذه الأقوال.
و قيل: المراد به جبريل، و قيل: أرواح الناس و قيامها مع الملائكة صفّاً إنّما هو بين النفختين قبل أن تلج الأجساد، و قيل: القرآن و المراد من قيامه ظهور آثاره يومئذ من سعادة المؤمنين به و شقاوة الكافرين.
و يدفعها أنّ هذه الثلاثة و إن اُطلق على كلّ منها الروح في كلامه تعالى لكنّه مع التقييد كقوله:( وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ) الحجر: 29، و قوله:( نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ) الشعراء: 193، و قوله:( قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ ) النحل: 102، و قوله:( فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا ) مريم: 17، و قوله:( وَ كَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ) الشورى: 52 و الروح في الآية الّتي نحن فيها مطلق، على أنّ في القولين الأخيرين تحكّماً ظاهراً.
و( صَفًّا) حال من الروح و الملائكة و هو مصدر اُريد به اسم الفاعل أي حال كونهم صافّين، و ربّما استفيد من مقابلة الروح للملائكة أنّ الروح وحده صفّ و الملائكة جميعاً صفّ.
و قوله:( لا يَتَكَلَّمُونَ ) بيان لقوله:( لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطاباً ) و ضمير الفاعل لأهل الجمع من الروح و الملائكة و الإنس و الجنّ على ما يفيده السياق.
و قيل: الضمير للروح و الملائكة، و قيل: للناس و وقوع( لا يَمْلِكُونَ ) بما مرّ
من معناه و( لا يَتَكَلَّمُونَ ) في سياق واحد لا يلائم شيئاً من القولين.
و قوله:( إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ ) بدل من ضمير الفاعل في( لا يَتَكَلَّمُونَ ) اُريد به بيان من له أن يتكلّم منهم يومئذ بإذن الله فالجملة في معنى قوله:( يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ) هود: 105 على ظاهر إطلاقه.
و قوله:( وَ قالَ صَواباً ) أي قال قولاً صواباً لا يشوبه خطأ و هو الحقّ الّذي لا يداخله باطل، و الجملة في الحقيقة قيد للإذن كأنّه قيل: إلّا من أذن له الرحمن و لا يأذن إلّا لمن قال صواباً فالآية في معنى قوله تعالى:( وَ لا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ ) الزخرف: 86.
و قيل:( إِلَّا مَنْ أَذِنَ ) إلخ استثناء ممّن يتكلّم فيه و المراد بالصواب التوحيد و قول لا إله إلّا الله و المعنى لا يتكلّمون في حقّ أحد إلّا في حقّ شخص أذن له الرحمن و قال ذلك الشخص في الدنيا صواباً أي أقرّ بالوحدانيّة و شهد أن لا إله إلّا الله فالآية في معنى قوله تعالى:( وَ لا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى ) الأنبياء: 28.
و يدفعه أنّ العناية الكلاميّة في المقام متعلّقة بنفي أصل الخطاب و التكلّم يومئذ من كلّ متكلّم لا بنفي التكلّم في كلّ أحد مع تسليم جواز أصل التكلّم فالمستثنون هم المتكلّمون المأذون لهم في أصل التكلّم من دون تعرّض لمن يتكلّم فيه.
( كلام فيما هو الروح في القرآن)
تكرّرت كلمة الروح - و المتبادر منه ما هو مبدأ الحياة - في كلامه تعالى و لم يقصرها في الإنسان أو في الإنسان و الحيوان فحسب بل أثبتها في غيرهما كما في قوله:( فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا ) مريم: 17، و قوله:( وَ كَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ) الشورى: 52 إلى غير ذلك فللروح مصداق في الإنسان و مصداق في غيره.
و الّذي يصلح أن يكون معرّفاً لها في كلامه تعالى ما في قوله:( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ) إسراء: 85 حيث أطلقها إطلاقاً و ذكر معرّفاً لها أنّها
من أمره و قد عرّف أمره بقوله:( إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ) يس: 83 فبيّن أنّه كلمة الإيجاد الّتي هي الوجود من حيث انتسابه إليه تعالى و قيامه به لا من حيث انتسابه إلى العلل و الأسباب الظاهريّة.
و بهذه العناية عدّ المسيحعليهالسلام كلمة له و روحاً منه إذ قال:( وَ كَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ ) النساء: 171 لمّا وهبه لمريمعليهاالسلام من غير الطرق العاديّة و يقرب منه في العناية قوله تعالى:( إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) آل عمران: 59.
و هو تعالى و إن ذكرها في أغلب كلامه بالإضافة و التقيد كقوله:( وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ) الحجر 29، و قوله:( وَ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ) السجدة: 9، و قوله:( فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا ) مريم: 17، و قوله:( وَ رُوحٌ مِنْهُ ) النساء: 171 و قوله:( وَ أَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ) البقرة: 87 إلى غير ذلك إلّا أنّه أوردها في بعض كلامه مطلقة من غير تقييد كقوله:( تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ) القدر: 4 و ظاهر الآية أنّها موجود مستقلّ و خلق سماويّ غير الملائكة، و نظير الآية بوجه قوله تعالى:( تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ) المعارج: 4.
و أمّا الروح المتعلّقة بالإنسان فقد عبّر عنها بمثل قوله:( وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ) ( وَ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ) و أتي بكلمة( مِنْ ) الدالّة على المبدئيّة و سمّاه نفخاً و عبّر عن الروح الّتي خصّها بالمؤمنين بمثل قوله:( وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ) المجادلة: 22 فأتى بالباء الدالّة على السببيّة و سمّاه تأييداً و تقوية، و عبّر عن الروح الّتي خصّها بالأنبياء بمثل قوله:( وَ أَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ) البقرة: 87 فأضاف الروح إلى القدس و هو النزاهة و الطهارة و سمّاه أيضاً تأييداً.
و بانضمام هذه الآيات إلى مثل آية سورة القدر يظهر أنّ نسبة الروح المضافة الّتي في هذه الآيات إلى الروح المطلقة المذكورة في سورة القدر نسبة الإفاضة إلى المفيض
و الظلّ إلى ذي الظلّ بإذن الله.
و كذلك الروح المتعلّقة بالملائكة من إفاضات الروح بإذن الله، و إنّما لم يعبّر في روح الملك بالنفخ و التأييد كالإنسان بل سمّاه روحاً كما في قوله تعالى:( فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا ) ، و قوله:( قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ ) النحل: 102، و قوله:( نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ) الشعراء: 193 لأنّ الملائكة أرواح محضة على اختلاف مراتبهم في القرب و البعد من ربّهم، و ما يتراءى من الأجسام لهم تمثّلات كما يشير إليه قوله تعالى:( فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا ) مريم: 17 و قد تقدّم الكلام في معنى التمثّل في ذيل الآية بخلاف الإنسان المخلوق مؤلّفاً من جسم ميت و روح حيّة فيناسبه التعبير بالنفخ كما في قوله( فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ) الحجر: 29.
و كما أوجب اختلاف الروح في خلق الملك و الإنسان اختلاف التعبير بالنفخ و عدمه كذلك اختلاف الروح من حيث أثرها و هو الحياة شرفاً و خسّة أوجب اختلاف التعبير بالنفخ و التأييد و عدّ الروح ذات مراتب مختلفة باختلاف أثر الحياة.
فمن الروح الروح المنفوخة في الإنسان قال:( وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ) .
و من الروح الروح المؤيّد بها المؤمن قال:( أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ) المجادلة: 22 و هي أشرف وجوداً و أعلى مرتبة و أقوى أثراً من الروح الإنسانيّة العامّة كما يفيده قوله تعالى و هو في معنى هذه الآية:( أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها ) الأنعام: 122 فقد عدّ المؤمن حيّاً ذا نور يمشي به و هو أثر الروح و الكافر ميتاً و هو ذو روح منفوخة فللمؤمن روح ليست للكافر ذات أثر ليس فيه.
و من ذلك يظهر أنّ من مراتب الروح ما هو في النبات لما فيه من أثر الحياة يدلّ على ذلك الآيات المتضمّنة لإحياء الأرض بعد موتها.
و من الروح الروح المؤيّد بها الأنبياء قال:( وَ أَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ) البقرة: 87 و سياق الآيات يدلّ على كون هذه الروح أشرف و أعلى مرتبة من غيرها ممّا في الإنسان.
و أمّا قوله:( يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ ) المؤمن: 15، و قوله:( وَ كَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ) الشورى: 52 فيقبل الانطباق على روح الإيمان و على روح القدس و الله أعلم.
و قد تقدّم بعض ما ينفع من الكلام في المقام في ذيل هذه الآيات الكريمة.
قوله تعالى: ( ذلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ) إشارة إلى يوم الفصل المذكور في السورة الموصوف بما مرّ من الأوصاف و هو في الحقيقة خاتمة الكلام المنعطفة إلى فاتحة السورة و ما بعده أعني قوله:( فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ مَآباً ) إلخ فضل تفريع على البيان السابق.
و الإشارة إليه بالإشارة البعيدة للدلالة على فخامة أمره و المراد بكونه حقّاً ثبوته حتماً مقضيّاً لا يتخلّف عن الوقوع.
قوله تعالى: ( فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ مَآباً ) أي مرجعاً إلى ربّه ينال به ثواب المتّقين و ينجو به من عذاب الطاغين، و الجملة كما أشرنا إليه تفريع على ما تقدّم من الإخبار بيوم الفصل و الاحتجاج عليه و وصفه، و المعنى إذا كان كذلك فمن شاء الرجوع إلى ربّه فليرجع.
قوله تعالى: ( ا أَنْذَرْناكُمْ عَذاباً قَرِيباً ) إلخ المراد به عذاب الآخرة، و كونه قريباً لكونه حقّاً لا ريب في إتيانه و كلّ ما هو آت قريب.
على أنّ الأعمال الّتي سيجزي بها الإنسان هي معه أقرب ما يكون منه.
و قوله:( يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ) أي ينتظر المرء جزاء أعماله الّتي قدّمتها يداه بالاكتساب، و قيل: المعنى ينظر المرء إلى ما قدّمت يداه من الأعمال لحضورها عنده قال تعالى:( يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ) آل عمران: 30.
و قوله:( يَقُولُ الْكافِرُ يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً ) أي يتمنّى من شدّة اليوم أن لو كان تراباً فاقداً للشعور و الإرادة فلم يعمل و لم يجز.
( بحث روائي)
في تفسير القمّيّ و قوله:( وَ فُتِحَتِ السَّماءُ فَكانَتْ أَبْواباً ) قال: تفتح أبواب الجنان، و قوله:( وَ سُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سَراباً ) قال: تصير الجبال مثل السراب الّذي يلمع في المفازة.
و فيه،: و قوله:( لابِثِينَ فِيها أَحْقاباً ) قال: الأحقاب السنين و الحقب سنة و السنة عددها ثلاثمائة و ستّون يوماً و اليوم كألف سنة ممّا تعدّون.
و في المجمع، روى نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : لا يخرج من النار من دخلها حتّى يمكث فيها أحقاباً و الحقب بضع و ستّون سنة و السنة ثلاثمائة و ستّون يوماً كلّ يوم كألف سنة ممّا تعدّون فلا يتّكلنّ أحد على أن يخرج من النار.
أقول: و أورد الرواية في الدرّ المنثور، و فيها ثمانون مكان ستّون و لفظ آخرها، قال ابن عمر: فلا يتّكلنّ أحد إلخ، و أورد أيضاً رواية اُخرى عنهصلىاللهعليهوآلهوسلم : أنّ الحقب أربعون سنة.
و فيه، و روى العيّاشيّ بإسناده عن حمران قال: سألت أباجعفرعليهالسلام عن هذه الآية فقال: هذه في الّذين يخرجون من النار، و روي عن الأحول مثله.
و في تفسير القمّيّ و قوله:( إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفازاً ) قال: يفوزون، قوله:( وَ كَواعِبَ أَتْراباً ) قال: جوار و أتراب لأهل الجنّة، و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرعليهالسلام قال في قوله:( إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفازاً ) قال: هي الكرامات( وَ كَواعِبَ أَتْراباً ) أي الفتيات النواهد.
و في الدرّ المنثور، أخرج ابن أبي حاتم و أبوالشيخ في العظمة و ابن مردويه عن ابن عبّاس أنّ النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: الروح جند من جنود الله ليسوا بملائكة لهم رؤس و أيد و أرجل ثمّ قرأ:( يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلائِكَةُ صَفًّا ) قال: هؤلاء جند و هؤلاء جند.
أقول: و قد تقدّمت الرواية في ذيل الآيات المشتملة على الروح عن أئمّة أهل البيتعليهمالسلام أنّ الروح خلق أعظم من جبرائيل و ميكائيل، و تقدّمت الرواية أيضاً عن عليّعليهالسلام : أنّ الروح غير الملائكة و استدلّعليهالسلام عليه بقوله تعالى:( يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ ) الآية.
نعم في رواية القمّيّ عن حمران أنّه ملك أعظم من جبرائيل و ميكائيل و كان مع رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم و هو مع الأئمّةعليهمالسلام ، و لعلّ المراد بالملك مطلق الموجود السماويّ أو هو من وهم بعض الرواة في النقل بالمعنى و لا دليل على انحصار الموجودات الأمريّة السماويّة في الملائكة بل الدليل على خلافه كما يستفاد من قوله تعالى لإبليس حين أبى عن السجود لآدم و قد سجد له الملائكة كلّهم أجمعون:( يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ ) ص: 75 و قد تقدّمت الإشارة إلى ذلك في تفسير الآية.
و في اُصول الكافي، بإسناده عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضيعليهالسلام قال قلت:( يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلائِكَةُ صَفًّا لا يَتَكَلَّمُونَ ) الآية قال نحن و الله المأذون لهم يوم القيامة و القائلون صواباً. قلت: ما تقولون إذا تكلّمتم؟ قال: نمجّد ربّنا و نصلّي على نبيّنا و نشفع لشيعتنا و لا يردّنا ربّنا الحديث.
أقول: و رواه في المجمع، عن العيّاشيّ مرفوعاً عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللهعليهالسلام .
و الرواية من قبيل ذكر بعض المصاديق فهناك شفعاء اُخر من الملائكة و الأنبياء و المؤمنين مأذون لهم في التكلّم، و هناك شهداء من الاُمم مأذون لهم في التكلّم على ما ينصّ عليه القرآن و الحديث.
( سورة النازعات مكّيّة و هي ستّ و أربعون آية)
( سورة النازعات الآيات 1 - 41)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ( 1 ) وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ( 2 ) وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا ( 3 ) فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا ( 4 ) فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ( 5 ) يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ( 6 ) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ( 7 ) قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ( 8 ) أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ( 9 ) يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ( 10 ) أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ( 11 ) قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ( 12 ) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ( 13 ) فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ( 14 ) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ( 15 ) إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ( 16 ) اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ( 17 ) فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ ( 18 ) وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ( 19 ) فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ ( 20 ) فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ( 21 ) ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ( 22 ) فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ( 23 ) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ( 24 ) فَأَخَذَهُ اللهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ( 25 ) إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ( 26 ) أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ( 27 ) رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا ( 28 ) وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ( 29 ) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا ( 30 ) أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ( 31 ) وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ( 32 ) مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ( 33 ) فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ ( 34 ) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ ( 35 )
وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ( 36 ) فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ( 37 ) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ( 38 ) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ( 39 ) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ( 40 ) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ( 41 )
( بيان)
في السورة أخبار مؤكّد بوقوع البعث و القيامة، و احتجاج عليه من طريق التدبير الربوبيّ المنتج أنّ الناس سينقسمون يومئذ طائفتين أصحاب الجنّة و أصحاب الجحيم و تختتم السورة بالإشارة إلى سؤالهم النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم عن وقت قيام الساعة و الجواب عنه.
و السورة مكّيّة بشهادة سياق آياتها.
قوله تعالى: ( وَ النَّازِعاتِ غَرْقاً وَ النَّاشِطاتِ نَشْطاً وَ السَّابِحاتِ سَبْحاً فَالسَّابِقاتِ سَبْقاً فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً ) اختلف المفسّرون في تفسير هذه الآيات الخمس اختلافاً عجيباً مع اتّفاقهم على أنّها إقسام، و قول أكثرهم بأنّ جواب القسم محذوف، و التقدير اُقسم بكذا و كذا لتبعثنّ.
فقوله:( وَ النَّازِعاتِ غَرْقاً ) قيل: المراد بها ملائكة الموت تنزع الأرواح من الأجساد، و( غَرْقاً ) مصدر مؤكّد بحذف الزوائد أي إغراقاً و تشديداً في النزع.
و قيل: المراد بها الملائكة الّذين ينزعون أرواح الكفّار من أجسادهم بشدّة، و قيل: هو الموت ينزع الأرواح من الأبدان نزعاً بالغاً.
و قيل: المراد بها النجوم تنزع من اُفق لتغيب في اُفق أي تطلع من مطالعها لتغرب في مغاربها، و قيل: المراد بها القسيّ تنزع بالسهم أي تمدّ بجذب وترها إغراقاً في المدّ فالإقسام بقسيّ المجاهدين في سبيل الله أو بالمجاهدين أنفسهم، و قيل: المراد بها الوحش تنزع إلى الكلإ.
و قوله:( وَ النَّاشِطاتِ نَشْطاً ) النشط الجذب و الخروج و الإخراج برفق و سهولة
و حلّ العقدة، قيل: المراد بها الملائكة الّذين يخرجون الأرواح من الأجساد، و قيل المراد بها خصوص الملائكة يخرجون أرواح المؤمنين من أجسادهم برفق و سهولة، كما أنّ المراد بالنازعات غرقاً الملائكة الّذين ينزعون أرواح الكفّار من أجسادهم.
و قيل: هم الملائكة الّذين ينشطون أرواح الكفّار من أجسادهم، و قيل: المراد بها أرواح المؤمنين أنفسهم، و قيل: هي النجوم تنشط و تذهب من اُفق إلى اُفق، و قيل: هي السهام تنشط من قسيّها في الغزوات، و قيل: هو الموت ينشط و يخرج الأرواح من الأجساد، و قيل: هي الوحش تنشط من قطر إلى قطر.
و قوله:( وَ السَّابِحاتِ سَبْحاً ) قيل: المراد بها الملائكة تقبض الأرواح فتسرع بروح المؤمن إلى الجنّة و بروح الكافر إلى النار، و السبح الإسراع في الحركة كما يقال للفرس سابح إذا أسرع في جريه، و قيل: المراد بها الملائكة يقبضون أرواح المؤمنين يسلّونها من الأبدان سلاً رفيقاً ثمّ يدعونها حتّى يستريح كالسابح بالشيء في الماء يرمي، و قيل: هي الملائكة ينزلون من السماء مسرعين، و قيل: هي النجوم تسبح في فلكها كما قال تعالى:( وَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ) .
و قيل: هي خيل الغزاة تسبح في عدوها و تسرع، و قيل: هي المنايا تسبح في نفوس الحيوان، و قيل: هي السفن تسبح في المياه، و قيل: السحاب، و قيل: دوابّ البحر.
و قوله:( فَالسَّابِقاتِ سَبْقاً ) قيل المراد بها مطلق الملائكة لأنّها سبقت ابن آدم بالخير و الإيمان و العمل الصالح، و قيل ملائكة الموت تسبق بروح المؤمن إلى الجنّة و بروح الكافر إلى النار، و قيل الملائكة القابضون لروح المؤمن تسبق بها إلى الجنّة، و قيل، ملائكة الوحي تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء، و قيل أرواح المؤمنين تسبق إلى الملائكة الّذين يقبضونها شوقاً إلى لقاء الله سبحانه، و قيل هي النجوم تسبق بعضها بعضاً في السير، و قيل هي خيل الغزاة تسبق بعضها بعضاً في الحرب، و قيل: هي المنايا تسبق الآمال.
و قوله:( فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً ) قيل: المراد بها مطلق الملائكة المدبّرين للاُمور، كذا فسّر الأكثرون حتّى ادّعى بعضهم اتّفاق المفسّرين عليه، و قيل المراد بها
الملائكة الأربعة المدبّرون لاُمور الدنيا: جبرائيل و ميكائيل و عزرائيل و إسرافيل، فجبرائيل يدبّر أمر الرياح و الجنود و الوحي، و ميكائيل يدبّر أمر القطر و النبات، و عزرائيل موكّل بقبض الأرواح، و إسرافيل يتنزّل بالأمر عليهم و هو صاحب الصور، و قيل: إنّها الأفلاك يقع فيها أمر الله فيجري بها القضاء في الدنيا.
و هناك قول بأنّ الإقسام في الآيات بمضاف محذوف و التقدير و ربّ النازعات نزعاً إلخ.
و أنت خبير بأنّ سياق الآيات الخمس سياق واحد متّصل متشابه الأجزاء لا يلائم كثيراً من هذه الأقوال القاضية باختلاف المعاني المقسم بها ككون المراد بالنازعات الملائكة القابضين لأرواح الكفّار، و بالناشطات الوحش، و بالسابحات السفن، و بالسابقات المنايا تسبق الآمال و بالمدبّرات الأفلاك.
مضافاً إلى أنّ كثيراً منها لا دليل عليها من جهة السياق إلّا مجرّد صلاحية اللفظ بحسب اللغة للاستعمال فيه أعمّ من الحقيقة و المجاز.
على أنّ كثيراً منها لا تناسب سياق آيات السورة الّتي تذكر يوم البعث و تحتجّ على وقوعه على ما تقدّم في سورة المرسلات من حديث المناسبة بين ما في كلامه تعالى من الإقسام و جوابه.
و الّذي يمكن أن يقال - و الله أعلم - أنّ ما في هذه الآيات من الأوصاف المقسم بها يقبل الانطباق على صفات الملائكة في امتثالها للأوامر الصادرة عليهم من ساحة العزّة المتعلّقة بتدبير اُمور هذا العالم المشهود ثمّ قيامهم بالتدبير بإذن الله.
و الآيات شديدة الشبه سياقاً بآيات مفتتح سورة الصافّات:( وَ الصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِراتِ زَجْراً فَالتَّالِياتِ ذِكْراً ) و آيات مفتتح سورة المرسلات:( وَ الْمُرْسَلاتِ عُرْفاً فَالْعاصِفاتِ عَصْفاً وَ النَّاشِراتِ نَشْراً فَالْفارِقاتِ فَرْقاً فَالْمُلْقِياتِ ذِكْراً ) و هي تصف الملائكة في امتثالهم لأمر الله غير أنّها تصف ملائكة الوحي، و الآيات في مفتتح هذه السورة تصف مطلق الملائكة في تدبيرهم أمر العالم بإذن الله.
ثمّ إنّ أظهر الصفات المذكورة في هذه الآيات الخمس في الانطباق على الملائكة
قوله:( فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً ) و قد أطلق التدبير و لم يقيّد بشيء دون شيء فالمراد به التدبير العالمي بإطلاقه، و قوله( أَمْراً ) تمييز أو مفعول به للمدبّرات و مطلق التدبير شأن مطلق الملائكة فالمراد بالمدبّرات مطلق الملائكة.
و إذ كان قوله:( فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً ) مفتتحاً بفاء التفريع الدالّة على تفرّع صفة التدبير على صفة السبق، و كذا قوله:( فَالسَّابِقاتِ سَبْقاً ) مقروناً بفاء التفريع الدالّة على تفرّع السبق على السبح دلّ ذلك على مجانسة المعاني المرادة بالآيات الثلاث:( وَ السَّابِحاتِ سَبْحاً فَالسَّابِقاتِ سَبْقاً فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً ) فمدلولها أنّهم يدبّرون الأمر بعد ما سبقوا إليه و يسبقون إليه بعد ما سبحوا أي أسرعوا إليه عند النزول فالمراد بالسابحات و السابقات هم المدبّرات من الملائكة باعتبار نزولهم إلى ما اُمروا بتدبيره.
فالآيات الثلاث في معنى قوله تعالى:( لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ ) الرعد: 11 على ما تقدّم من توضيح معناه فالملائكة ينزلون على الأشياء و قد تجمّعت عليها الأسباب و تنازعت فيها وجوداً و عدماً و بقاء و زوالاً و في مختلف أحوالها فما قضاه الله فيها من الأمر و أبرم قضاءه أسرع إليه الملك المأمور به - بما عيّن له من المقام - و سبق غيره و تمّم السبب الّذي يقتضيه فكان ما أراده الله فافهم ذلك.
و إذا كان المراد بالآيات الثلاث الإشارة إلى إسراع الملائكة في النزول على ما اُمروا به من أمر و سبقهم إليه و تدبيره تعيّن حمل قوله:( وَ النَّازِعاتِ غَرْقاً وَ النَّاشِطاتِ نَشْطاً ) على انتزاعهم و خروجهم من موقف الخطاب إلى ما اُمروا به فنزعهم غرقاً شروعهم في النزول نحو المطلوب بشدّة و جدّ، و نشطهم خروجهم من موقفهم نحوه كما أنّ سبحهم إسراعهم إليه بعد الخروج و يتعقّب ذلك سبقهم إليه و تدبير الأمر بإذن الله.
فالآيات الخمس أقسام بما يتلبّس به الملائكة من الصفات عند ما يؤمرون بتدبير أمر من اُمور هذا العالم المشهود من حين يأخذون في النزول إليه إلى تمام التدبير.
و فيها إشارة إلى نظام التدبير الملكوتي عند حدوث الحوادث كما أنّ الآيات التالية أعني قوله:( هَلْ أَتاكَ ) إلخ إشارة إلى التدبير الربوبيّ الظاهر في هذا العالم.
و في التدبير الملكوتيّ حجّة على البعث و الجزاء كما أنّ في التدبير الدنيويّ المشهود حجّة عليه على ما سيوافيك إن شاء الله بيانه.
هذا ما يعطيه التدبّر في سياق الآيات الكريمة و يؤيّده بعض التأييد ما سيأتي من الأخبار في البحث الروائيّ الآتي إن شاء الله.
( كلام في أنّ الملائكة وسائط في التدبير)
الملائكة وسائط بينه تعالى و بين الأشياء بدءاً و عوداً على ما يعطيه القرآن الكريم بمعنى أنّهم أسباب للحوادث فوق الأسباب المادّيّة في العالم المشهود قبل حلول الموت و الانتقال إلى نشأة الآخرة و بعده.
أمّا في العود أعني حال ظهور آيات الموت و قبض الروح و إجراء السؤال و ثواب القبر و عذابه و إماتة الكلّ بنفخ الصور و إحيائهم بذلك و الحشر و إعطاء الكتاب و وضع الموازين و الحساب و السوق إلى الجنّة و النار فوساطتهم فيها غنيّ عن البيان، و الآيات الدالّة على ذلك كثيرة لا حاجة إلى إيرادها، و الأخبار المأثورة فيها عن النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم و أئمّة أهل البيتعليهمالسلام فوق حدّ الإحصاء.
و كذا وساطتهم في مرحلة التشريع من النزول بالوحي و دفع الشياطين عن المداخلة فيه و تسديد النبيّ و تأييد المؤمنين و تطهيرهم بالاستغفار.
و أمّا وساطتهم في تدبير الاُمور في هذه النشأة فيدلّ عليها ما في مفتتح هذه السورة من إطلاق قوله:( وَ النَّازِعاتِ غَرْقاً وَ النَّاشِطاتِ نَشْطاً وَ السَّابِحاتِ سَبْحاً فَالسَّابِقاتِ سَبْقاً فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً ) بما تقدّم من البيان.
و كذا قوله تعالى:( جاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ ) فاطر: 1 الظاهر بإطلاقه - على ما تقدّم من تفسيره - في أنّهم خلقوا و شأنهم أن يتوسّطوا بينه تعالى و بين خلقه و يرسلوا لإنفاذ أمره الّذي يستفاد من قوله
تعالى في صفتهم:( بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ) الأنبياء: 27، و قوله:( يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ ) النحل: 50 و في جعل الجناح لهم إشارة ذلك.
فلا شغل للملائكة إلّا التوسّط بينه تعالى و بين خلقه بإنفاذ أمره فيهم و ليس ذلك على سبيل الاتّفاق بأن يجري الله سبحانه أمراً بأيديهم ثمّ يجري مثله لا بتوسيطهم فلا اختلاف و لا تخلّف في سنّته تعالى:( إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ) هود: 56، و قال:( فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيلًا وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحْوِيلًا ) فاطر: 43.
و من الوساطة كون بعضهم فوق بعض مقاماً و أمر العالي منهم السافل بشيء من التدبير فإنّه في الحقيقة توسّط من المتبوع بينه تعالى و بين تابعه في إيصال أمر الله تعالى كتوسّط ملك الموت في أمر بعض أعوانه بقبض روح من الأرواح، قال تعالى حاكياً عن الملائكة:( وَ ما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ ) الصافّات: 164، و قال:( مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ) التكوير: 21، و قال:( حَتَّى إِذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قالُوا ما ذا قالَ رَبُّكُمْ قالُوا الْحَقَّ ) سبأ: 23.
و لا ينافي هذا الّذي ذكر من توسّطهم بينه تعالى و بين الحوادث أعني كونهم أسباباً تستند إليها الحوادث استناد الحوادث إلى أسبابها القريبة المادّيّة فإنّ السببيّة طوليّة لا عرضيّة أي إنّ السبب القريب سبب للحادث و السبب البعيد سبب للسبب.
كما لا ينافي توسّطهم و استناد الحوادث إليهم استناد الحوادث إليه تعالى و كونه هو السبب الوحيد لها جميعاً على ما يقتضيه توحيد الربوبيّة فإنّ السببيّة طوليّة كما سمعت لا عرضيّة و لا يزيد استناد الحوادث إلى الملائكة استنادها إلى أسبابها الطبيعيّة القريبة و قد صدّق القرآن الكريم استناد الحوادث إلى الحوادث الطبيعيّة كما صدّق استنادها إلى الملائكة.
و ليس لشيء من الأسباب استقلال قباله تعالى حتّى ينقطع عنه فيمنع ذلك استناد ما استند إليه إلى الله سبحانه على ما يقول به الوثنيّة من تفويضه تعالى تدبير الأمر إلى الملائكة المقرّبين فالتوحيد القرآنيّ ينفي الاستقلال عن كلّ شيء من كلّ جهة: لا يملكون لأنفسهم نفعاً و لا ضرّاً و لا موتاً و لا حياة و لا نشوراً.
فمثل الأشياء في استنادها إلى أسبابها المترتّبة القريبة و البعيدة و انتهائها إلى الله سبحانه بوجه بعيد كمثل الكتابة يكتبها الإنسان بيده و بالقلم فللكتابة استناد إلى القلم ثمّ إلى اليد الّتي توسّلت إلى الكتابة بالقلم، و إلى الإنسان الّذي توسّل إليها باليد و بالقلم، و السبب بحقيقة معناه هو الإنسان المستقلّ بالسببيّة من غير أن ينافي سببيته استناد الكتابة بوجه إلى اليد و إلى القلم.
و لا منافاة أيضاً بين ما تقدّم أنّ شأن الملائكة هو التوسّط في التدبير و بين ما يظهر من كلامه تعالى أنّ بعضهم أو جميعهم مداومون على عبادته تعالى و تسبيحه و السجود له كقوله:( وَ مَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَ لا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ لا يَفْتُرُونَ ) الأنبياء: 20، و قوله:( إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَ يُسَبِّحُونَهُ وَ لَهُ يَسْجُدُونَ ) الأعراف: 206.
و ذلك لجواز أن تكون عبادتهم و سجودهم و تسبيحهم عين عملهم في التدبير و امتثالهم الأمر الصادر عن ساحة العزّة بالتوسّط كما ربّما يومئ إليه قوله تعالى:( وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ دابَّةٍ وَ الْمَلائِكَةُ وَ هُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ ) النحل: 49.
قوله تعالى: ( يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ) فسّرت الراجفة بالصيحة العظيمة الّتي فيها تردّد و اضطراب و الرادفة بالمتأخّرة التابعة، و عليه تنطبق الآيتان على نفختي الصور الّتي يدلّ عليهما قوله تعالى:( وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرى فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ ) الزمر: 68.
و قيل: الراجفة بمعنى المحرّكة تحريكاً شديداً - فإنّ الرجف يستعمل لازماً بمعنى التحرّك الشديد، و متعدّياً بمعنى التحريك الشديد - و المراد بها أيضاً النفخة الاُولى المحرّكة للأرض و الجبال، و بالرادفة النفخة الثانية المتأخّرة عن الاُولى.
و قيل: المراد بالراجفة الأرض و بالرادفة السماوات و الكواكب الّتي ترجف و تضطرب و تنشقّ، و تتلاشى و الوجهان لا يخلوان من بعد و لا سيّما الأخير.
و الأنسب بالسياق على أيّ حال كون قوله:( يَوْمَ تَرْجُفُ ) إلخ ظرفاً لجواب القسم المحذوف للدلالة على فخامته و بلوغه الغاية في الشدّة و هو لتبعثنّ، و قيل: إنّ( يَوْمَ ) منصوب على معنى قلوب يومئذ واجفة يوم ترجف الراجفة، و لا يخلو من بعد.
قوله تعالى: ( قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ واجِفَةٌ أَبْصارُها خاشِعَةٌ ) تنكير( قُلُوبٌ ) للتنويع و هو مبتدأ خبره( واجِفَةٌ ) و الوجيف الاضطراب، و( يَوْمَئِذٍ ) ظرف متعلّق بواجفة و الجملة استئناف مبيّن لصفة اليوم.
و قوله:( أَبْصارُها خاشِعَةٌ ) ضمير( أَبْصارُها ) للقلوب و نسبة الأبصار و إضافتها إلى القلوب لمكان أنّ المراد بالقلوب في أمثال هذه المواضع الّتي تضاف إليها الصفات الإدراكيّة كالعلم و الخوف و الرجاء و ما يشبهها هي النفوس، و قد تقدّمت الإشارة إليها.
و نسبة الخشوع إلى الأبصار و هو من أحوال القلب إنّما هي لظهور أثره الدالّ عليه في الأبصار أقوى من سائر الأعضاء.
قوله تعالى: ( يَقُولُونَ أَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحافِرَةِ ) إخبار و حكاية لقولهم في الدنيا استبعاداً منهم لوقوع البعث و الجزاء و إشارة إلى أنّ هؤلاء الّذين لقلوبهم وجيف و لأبصارهم خشوع يوم القيامة هم الّذين ينكرون البعث و هم في الدنيا و يقولون كذا و كذا.
و الحافرة - على ما قيل - أوّل الشيء و مبتداه، و الاستفهام للإنكار استبعاداً، و المعنى يقول: هؤلاء أ إنّا لمردودون بعد الموت إلى حالتنا الاُولى و هي الحياة.
و قيل: الحافرة بمعنى المحفورة و هي أرض القبر، و المعنى أ نرد من قبورنا بعد موتنا أحياء، و هو كما ترى.
و قيل: الآية تخبر عن اعترافهم بالبعث يوم القيامة، و الكلام كلامهم بعد الإحياء و الاستفهام للاستغراب كأنّهم لمّا بعثوا و شاهدوا ما شاهدوا يستغربون ما شاهدوا فيستفهمون عن الردّ إلى الحياة بعد الموت.
و هو معنى حسن لو لم يخالف ظاهر السياق.
قوله تعالى: ( أَ إِذا كُنَّا عِظاماً نَخِرَةً ) تكرار للاستفهام لتأكيد الاستبعاد فلو كانت الحياة بعد الموت مستبعدة فهي مع فرض نخر العظام و تفتّت الأجزاء أشدّ استبعاداً، و النخر بفتحتين البلى و التفتّت يقال: نخر العظم ينخر نخراً فهو ناخر و نخر.
قوله تعالى: ( قالُوا تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خاسِرَةٌ ) الإشارة بتلك إلى معنى الرجعة المفهوم من قوله( أَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحافِرَةِ ) و الكرّة الرجعة و العطفة، و عدّ الكرّة خاسرة إمّا مجاز و الخاسر بالحقيقة صاحبها، أو الخاسرة بمعنى ذات خسران، و المعنى قالوا: تلك الرجعة - و هي الرجعة إلى الحياة بعد الموت - رجعة متلبّسة بالخسران.
و هذا قول منهم أوردوه استهزاء - على أن يكون قولهم:( أَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ ) إلخ ممّا قالوه في الدنيا - و لذا غيّر السياق و قال:( قالُوا تِلْكَ إِذاً ) إلخ بعد قوله:( يَقُولُونَ أَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ ) إلخ و أمّا على تقدير أن يكون ممّا سيقولونه عند البعث فهو قول منهم على سبيل التشؤم و التحسّر.
قوله تعالى: ( فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ فَإِذا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ) ضمير( هِيَ ) للكرّة و قيل: للرادفة و المراد بها النفخة الثانية، و الزجر طرد بصوت و صياح عبّر عن النفخة
الثانية بالزجرة لما فيها من نقلهم من نشأة الموت إلى نشاة الحياة و من بطن الأرض إلى ظهرها، و( فَإِذا ) فجائيّة، و الساهرة الأرض المستوية أو الأرض الخالية من النبات.
و الآيتان في محلّ الجواب عمّا يدلّ عليه قولهم:( أَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ ) إلخ من استبعاد البعث و استصعابه و المعنى لا يصعب علينا إحياؤهم بعد الموت و كرّتهم فإنّما كرّتهم - أو الرادفة الّتي هي النفخة الثانية - زجرة واحدة فإذا هم أحياء على وجه الأرض بعد ما كانوا أمواتاً في بطنها.
فالآيتان في معنى قوله تعالى:( وَ ما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ) النحل: 77.
قوله تعالى: ( هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسى ) الآية إلى تمام اثنتي عشرة آية إشارة إلى إجمال قصّة موسى و رسالته إلى فرعون و ردّه دعوته إلى أن أخذه الله نكال الآخرة و الاُولى.
و فيها عظة و إنذار للمشركين المنكرين للبعث و قد توسّلوا به إلى ردّ الدعوة الدينيّة إذ لا معنى لتشريع الدين لو لا المعاد، و فيها مع ذلك تسلية للنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم من تكذيب قومه، و تهديد لهم كما يؤيّده توجيه الخطاب في قوله:( هَلْ أَتاكَ ) .
و في القصّة مع ذلك كلّه حجّة على وقوع البعث و الجزاء فإنّ هلاك فرعون و جنوده تلك الهلكة الهائلة دليل على حقّيّة رسالة موسى من جانب الله إلى الناس و لا تتمّ رسالته من جانبه تعالى إلّا بربوبيّة منه تعالى للناس على خلاف ما يزعمه المشركون أن لا ربوبيّة له تعالى بالنسبة إلى الناس و أنّ هناك أرباباً دونه و أنّه سبحانه ربّ الأرباب لا غير.
ففي قوله:( هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسى ) استفهام بداعي ترغيب السامع في استماع الحديث ليتسلّى به هو و يكون للمنكرين إنذاراً بما فيه من ذكر العذاب و إتماماً للحجّة كما تقدّم.
و لا ينافي هذا النوع من الاستفهام تقدّم علم السامع بالحديث لأنّ الغرض
توجيه نظر السامع إلى الحديث دون السؤال و الاستعلام حقيقة فمن الممكن أن تكون الآيات أوّل ما يقصّه الله من قصّة موسى أو تكون مسبوقة بذكر قصّته كما في سورة المزّمّل إجمالاً - و هي أقدم نزولاً من سورة النازعات - و في سورة الأعراف و طه و غيرهما تفصيلاً.
قوله تعالى: ( إِذْ ناداهُ رَبُّهُ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً ) ظرف للحديث و هو أوّل ما أوحى الله إليه فقلّده الرسالة، و طوى اسم للوادي المقدّس.
قوله تعالى: ( اذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى ) تفسير للنداء، و قيل: الكلام على تقدير القول أي قائلاً اذهب إلخ أو بتقدير أن المفسّرة أي أن اذهب إلخ و في الوجهين أنّ التقدير مستغنى عنه، و قوله:( إِنَّهُ طَغى ) تعليل للأمر.
قوله تعالى: ( فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلى أَنْ تَزَكَّى ) متعلّق( إِلى ) محذوف و التقدير هل لك ميل إلى أن تتزكّى أو ما في معناه، و المراد بالتزكّي التطهّر من قذارة الطغيان.
قوله تعالى: ( وَ أَهْدِيَكَ إِلى رَبِّكَ فَتَخْشى ) عطف على قوله:( تَزَكَّى ) و المراد بهدايته إيّاه إلى ربّه - كما قيل - تعريفه له و إرشاده إلى معرفته تعالى و تترتّب عليه الخشية منه الرادعة عن الطغيان و تعدّي طور العبوديّة قال تعالى:( إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ ) فاطر: 28.
و المراد بالتزكّي إن كان هو التطهّر عن الطغيان بالتوبة و الرجوع إلى الله تعالى كانت الخشية مترتّبة عليه و المراد بها الخشية الملازمة للإيمان الداعية إلى الطاعة و الرادعة عن المعصية، و إن كان هو التطهّر بالطاعة و تجنّب المعصية كان قوله:( وَ أَهْدِيَكَ إِلى رَبِّكَ فَتَخْشى ) مفسّراً لما قبله و العطف عطف تفسير.
قوله تعالى: ( فَأَراهُ الْآيَةَ الْكُبْرى ) الفاء فصيحة و في الكلام حذف و تقدير و الأصل فأتاه و دعاه فأراه إلخ.
و المراد بالآية الكبرى على ما يظهر من تفصيل القصّة آية العصا، و قيل: المراد بها مجموع معجزاته الّتي أراها فرعون و ملأه و هو بعيد.
قوله تعالى: ( فَكَذَّبَ وَ عَصى ) أي كذّب موسى فجحد رسالته و سمّاه ساحراً
و عصاه فيما أمره به أو عصى الله.
قوله تعالى: ( ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعى ) الإدبار التولّي و السعي هو الجدّ و الاجتهاد أي ثمّ تولّى فرعون يجدّ و يجتهد في إبطال أمر موسى و معارضته.
قوله تعالى: ( فَحَشَرَ فَنادى ) الحشر جمع الناس بإزعاج و المراد به جمعه الناس من أهل مملكته كما يدلّ عليه تفريع قوله:( فَنادى فَقالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى ) عليه فإنّه كان يدّعي الربوبيّة لأهل مملكته جميعاً لا لطائفة خاصّة منهم.
و قيل: المراد بالحشر جمع السحرة لقوله تعالى:( فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ ) الشعراء: 53، و قوله:( فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتى ) طه: 60 و فيه أنّه لا دليل على كون المراد بالحشر في هذه الآية هو عين المراد بالحشر و الجمع في تينك الآيتين.
قوله تعالى: ( فَقالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى ) دعوى الربوبيّة و ظاهره أنّه يدّعي أنّه أعلى في الربوبيّة من سائر الأرباب الّتي كان يقول بها قومه الوثنيّون فيفضّل نفسه على سائر آلهتهم.
و لعلّ مراده بهذا التفضيل مع كونه وثنيّاً يعبد الآلهة كما يدلّ عليه قوله تعالى حكاية عن ملائه يخاطبونه:( أَ تَذَرُ مُوسى وَ قَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ يَذَرَكَ وَ آلِهَتَكَ ) الأعراف: 127 أنّه أقرب الآلهة منهم تجري بيده أرزاقهم و تصلح بأمره شؤن حياتهم و يحفظ بمشيّته شرفهم و سؤددهم، و سائر الآلهة ليسوا على هذه الصفة.
و قيل: مراده بما قال تفضيل نفسه على كلّ من يلي اُمورهم و محصّله دعوى الملك و أنّه فوق سائر أولياء اُمور المملكة من حكّام و عمّال فيكون في معنى قوله فيما حكاه الله عنه إذ قال:( وَ نادى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قالَ يا قَوْمِ أَ لَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ ) الآية الزخرف: 51.
و هو خلاف ظاهر الكلام و فيما قال قوله لملائه:( يا أَيُّهَا الْمَلَأُ ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي ) القصص: 38، و قوله لموسى:( لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلهَاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ
مِنَ الْمَسْجُونِينَ ) الشعراء: 29.
قوله تعالى: ( فَأَخَذَهُ اللهُ نَكالَ الْآخِرَةِ وَ الْأُولى ) الأخذ كناية عن التعذيب، و النكال التعذيب الّذي يردع من رآه أو سمعه عن تعاطي مثله، و عذاب الآخرة نكال حيث إنّ من شأنه أن يردع من سمعه عن تعاطي ما يؤدّي إليه من المعصية كما أنّ عذاب الاستئصال في الدنيا نكال.
و المعنى: فأخذ الله فرعون أي عذّبه و نكله نكال الآخرة و الاُولى و أمّا عذاب الدنيا فإغراقه و إغراق جنوده، و أمّا عذاب الآخرة فعذابه بعد الموت، فالمراد بالاُولى و الآخرة الدنيا و الآخرة.
و قيل: المراد بالآخرة كلمته الآخرة،( أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى ) و بالاُولى كلمته الاُولى قالها قبل ذلك:( ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي ) فأخذه الله بهاتين الكلمتين و نكله نكالهما، و لا يخلو هذا المعنى من خفاء.
و قيل: المراد بالاُولى تكذيبه و معصيته المذكوران في أوّل القصّة و بالاُخرى كلمة - أنا ربّكم الأعلى - المذكورة في آخرها، و هو كسابقه.
و قيل: الاُولى أوّل معاصيه و الاُخرى آخرها و المعنى أخذه الله نكال مجموع معاصيه و لا يخلو أيضاً من خفاء.
قوله تعالى: ( إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشى ) الإشارة إلى حديث موسى، و الظاهر أنّ مفعول( يَخْشى ) منسيّ معرض عنه، و المعنى أنّ في هذا الحديث - حديث موسى - لعبرة لمن كان له خشية و كان من غريزته أن يخشى الشقاء و العذاب و الإنسان من غريزته ذلك ففيه عبرة لمن كان إنساناً مستقيم الفطرة.
و قيل: المفعول محذوف و التقدير لمن يخشى الله و الوجه السابق أبلغ.
قوله تعالى: ( أَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها - إلى قوله -وَ لِأَنْعامِكُمْ ) خطاب توبيخيّ للمشركين المنكرين للبعث المستهزئين به على سبيل العتاب و يتضمّن الجواب عن استبعادهم البعث بقولهم:( أَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحافِرَةِ أَ إِذا كُنَّا عِظاماً نَخِرَةً ) بأنّ الله خلق ما هو أشدّ منكم خلقاً فهو على خلقكم و إنشائكم النشأة الاُخرى لقدير.
و يتضمّن أيضاً الإشارة إلى الحجّة على وقوع البعث حيث يذكر التدبير العامّ العالميّ و ارتباطه بالعالم الإنسانيّ و لازمه ربوبيّته تعالى، و لازم الربوبيّة صحّة النبوّة و جعل التكاليف، و لازم ذلك الجزاء الّذي موطنه البعث و الحشر، و لذا فرّع عليه حديث البعث بقوله:( فإذا جاءت الطامة الكبرى) إلخ.
فقوله:( أَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ ) استفهام توبيخيّ بداعي رفع استبعادهم البعث بعد الموت، و الإشارة إلى تفصيل خلق السماء بقوله:( بَناها ) إلخ دليل أنّ المراد به تقرير كون السماء أشدّ خلقاً.
و قوله:( بَناها ) استئناف و بيان تفصيليّ لخلق السماء.
و قوله:( رَفَعَ سَمْكَها فَسَوَّاها ) أي رفع سقفها و ما ارتفع منها، و تسويتها ترتيب أجزائها و تركيبها بوضع كلّ جزء في موضعه الّذي تقتضيه الحكمة كما في قوله:( فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ) الحجر: 29.
و قوله:( وَ أَغْطَشَ لَيْلَها وَ أَخْرَجَ ضُحاها ) أي أظلم ليلها و أبرز نهارها، و الأصل في معنى الضحى انبساط الشمس و امتداد النهار اُريد به مطلق النهار بقرينة المقابلة و نسبة الليل و الضحى إلى السماء لأنّ السبب الأصليّ لها سماويّ و هو ظهور الأجرام المظلمة بشروق الأنوار السماويّة كنور الشمس و غيره و خفاؤها بالاستتار و لا يختصّ الليل و النهار بالأرض الّتي نحن عليها بل يعمّان سائر الأجرام المظلمة المستنيرة.
و قوله:( وَ الْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها ) أي بسطها و مدّها بعد ما بنى السماء و رفع سمكها و سوّاها و أغطش ليلها و أخرج ضحاها.
و قيل: المعنى و الأرض مع ذلك دحاها كما في قوله:( عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنِيمٍ ) و قد تقدّم كلام فيما يظهر من كلامه تعالى في خلق السماء و الأرض في تفسير سورة الم السجدة و ذكر بعضهم أنّ الدحو بمعنى الدحرجة.
و قوله:( أَخْرَجَ مِنْها ماءَها وَ مَرْعاها ) قيل: المرعى يطلق على الرعي بالكسر فالسكون و هو الكلأ كما يجيء مصدراً ميميّاً، و اسم زمان و مكان، و المراد بإخراج مائها منها تفجير العيون و إجراء الأنهار عليها، و إخراج المرعى إنبات النبات عليها
ممّا يتغذّى به الحيوان و الإنسان فالظاهر أنّ المراد بالمرعى مطلق النبات الّذي يتغذّى به الحيوان و الإنسان كما يشعر به قوله:( مَتاعاً لَكُمْ وَ لِأَنْعامِكُمْ ) لا ما يختصّ بالحيوان كما هو الغالب في استعماله.
و قوله:( وَ الْجِبالَ أَرْساها ) أي أثبتها على الأرض لئلّا تميد بكم و ادّخر فيها المياه و المعادن كما ينبئ عنه سائر كلامه تعالى.
و قوله:( مَتاعاً لَكُمْ وَ لِأَنْعامِكُمْ ) أي خلق ما ذكر من السماء و الأرض و دبّر ما دبّر من أمرهما ليكون متاعاً لكم و لأنعامكم الّتي سخّرها لكم تتمتّعون به في حياتكم فهذا الخلق و التدبير الّذي فيه تمتيعكم يوجب عليكم معرفة ربّكم و خوف مقامه و شكر نعمته فهناك يوم تجزون فيه بما عملتم في ذلك إن خيراً فخيراً و إن شرّاً فشرّاً كما أنّ هذا الخلق و التدبير أشدّ من خلقكم فليس لكم أن تستبعدوا خلقكم ثانياً و تستصعبوه عليه تعالى.
قوله تعالى: ( فَإِذا جاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرى ) في المجمع: و الطامّة العالية الغالبة يقال: هذا أطمّ من هذا أي أعلى منه، و طمّ الطائر الشجرة أي علاها و تسمّى الداهية الّتي لا يستطاع دفعها طامّة. انتهى، فالمراد بالطامّة الكبرى القيامة لأنّها داهية تعلو و تغلب كلّ داهية هائلة، و هذا معنى اتّصافها بالكبرى و قد اُطلقت إطلاقاً.
و تصدير الجملة بفاء التفريع للإشارة إلى أنّ مضمونها أعني مجيء القيامة من لوازم خلق السماء و الأرض و جعل التدبير الجاري فيهما المترتّبة على ذلك كما تقدّمت الإشارة إليه.
قوله تعالى: ( يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ ما سَعى ) ظرف لمجيء الطامّة الكبرى، و السعي هو العمل بجدّ.
قوله تعالى: ( وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرى ) التبريز الإظهار و مفعول( يَرى ) منسيّ معرض عنه و المراد بمن يرى من له بصر يرى به، و المعنى و اُظهرت الجحيم بكشف الغطاء عنها لكلّ ذي بصر فيشاهدونها مشاهدة عيان.
فالآية في معنى قوله تعالى:( لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ
فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ) ق: 22 غير أنّ آية ق أوسع معنى.
و الآية ظاهرة في أنّ الجحيم مخلوقة قبل يوم القيامة و إنّما تظهر يومئذ ظهوراً بكشف الغطاء عنها.
قوله تعالى: ( فَأَمَّا مَنْ طَغى وَ آثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوى وَ أَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى ) تفصيل حال الناس يومئذ في انقسامهم قسمين اُقيم مقام الإجمال الّذي هو جواب إذا المحذوف استغناء بالتفصيل عن الإجمال، و التقدير فإذا جاءت الطامّة الكبرى انقسم الناس قسمين فأمّا من طغى إلخ.
و قد قسّم تعالى الناس في الآيات الثلاث إلى أهل الجحيم و أهل الجنّة - و قدّم صفة أهل الجحيم لأنّ وجه الكلام إلى المشركين - و عرّف أهل الجحيم بما وصفهم به في قوله:( مَنْ طَغى وَ آثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا ) و قابل تعريفهم بتعريف أهل الجنّة بقوله:( مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى ) و سبيل ما وصف به الطائفتين على أيّ حال سبيل بيان الضابط.
و إذ كانت الطائفتان متقابلتين بحسب حالهما كان ما بيّن لكلّ منهما من الوصف مقابلاً لوصف الآخر فوصف أهل الجنّة بالخوف من مقام ربّهم - و الخوف تأثّر الضعيف المقهور من القويّ القاهر و خشوعه و خضوعه له - يقتضي كون طغيان أهل الجحيم - و الطغيان التعدّي عن الحدّ - هو عدم تأثّرهم من مقام ربّهم بالاستكبار و خروجهم عن زيّ العبوديّة فلا يخشعون و لا يخضعون و لا يجرون على ما أراده منهم و لا يختارون ما اختاره لهم من السعادة الخالدة بل ما تهواه أنفسهم من زينة الحياة الدنيا.
فمن لوازم طغيانهم اختيارهم الحياة الدنيا و هو الّذي وصفهم به بعد وصفهم بالطغيان إذ قال:( وَ آثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا ) .
و إذ كان من لوازم الطغيان رفض الآخرة و إيثار الحياة الدنيا و هو اتّباع النفس فيما تريده و طاعتها فيما تهواه و مخالفته تعالى فيما يريده كان لما يقابل الطغيان من
الوصف و هو الخوف ما يقابل الإيثار و اتّباع هوى النفس و هو قريحة الردع عن الإخلاد إلى الأرض و نهى النفس عن اتّباع الهوى و هو قوله في وصف أهل الجنّة بعد وصفهم بالخوف:( وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى ) .
و إنّما أخذ في وصفه النهي عن الهوى دون ترك اتّباعه عملاً لأنّ الإنسان ضعيف ربّما ساقته الجهالة إلى المعصية من غير استكبار و الله واسع المغفرة قال تعالى( وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَساؤُا بِما عَمِلُوا وَ يَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ واسِعُ الْمَغْفِرَةِ ) النجم: 32، و قال:( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً ) النساء: 31.
و يتحصّل معنى الآيات الثلاث في إعطاء الضابط في صفة أهل الجحيم و أهل الجنّة في أنّ أهل الجحيم أهل الكفر و الفسوق و أهل الجنّة أهل الإيمان و التقوى، و هناك غير الطائفتين طوائف اُخر من المستضعفين و الّذين اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً و آخر سيّئا و غيرهم أمرهم إلى الله سبحانه عسى أن يشملهم المغفرة بشفاعة و غيرها.
فقوله:( فَأَمَّا مَنْ طَغى - إلى قوله -هِيَ الْمَأْوى ) أي هي مأواه على أن تكون اللّام عوضاً عن الضمير أو الضمير محذوف و التقدير هي المأوى له.
و قوله:( وَ أَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ ) إلخ المقام اسم مكان يراد به المكان الّذي يقوم فيه جسم من الأجسام و هو الأصل في معناه ككونه اسم زمان و مصدراً ميميّاً لكن ربّما يعتبر ما عليه الشيء من الصفات و الأحوال محلاً و مستقرّاً للشيء بنوع من العناية فيطلق عليه المقام كالمنزلة كما في قوله تعالى في الشهادة:( فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما ) المائدة: 107 و قول نوحعليهالسلام لقومه على ما حكاه الله:( إِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقامِي وَ تَذْكِيرِي بِآياتِ اللهِ ) يونس: 71، و قول الملائكة على ما حكاه الله:( وَ ما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ ) الصافّات: 164.
فمقامه تعالى المنسوب إليه بما أنّه ربّ هو صفة ربوبيّته بما تستلزمه أو تتوقّف
عليه من صفاته الكريمة كالعلم و القدرة المطلقة و القهر و الغلبة و الرحمة و الغضب و ما يناسبها قال إيذاناً به:( وَ لا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَ مَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوى وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى ) طه: 82، و قال:( نَبِّئْ عِبادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَ أَنَّ عَذابِي هُوَ الْعَذابُ الْأَلِيمُ ) الحجر: 50.
فمقامه تعالى الّذي يخوّف منه عباده مرحلة ربوبيّته الّتي هي المبدأ لرحمته و مغفرته لمن آمن و اتّقى و لأليم عذابه و شديد عقابه لمن كذّب و عصى.
و قيل: المراد بمقام ربّه مقامه من ربّه يوم القيامة حين يسأله عن أعماله و هو كما ترى.
و قيل: معنى خاف مقام ربّه خاف ربّه بطريق الإقحام كما قيل في قوله( أَكْرِمِي مَثْواهُ ) .
( بحث روائي)
في الفقيه، و روى عليّ بن مهزيار قال: قلت لأبي جعفرعليهالسلام : قوله عزّوجلّ:( وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى وَ النَّهارِ إِذا تَجَلَّى ) و قوله عزّوجلّ:( وَ النَّجْمِ إِذا هَوى ) و ما أشبه هذا؟ فقال إنّ لله عزّوجلّ أن يقسم من خلقه بما شاء و ليس لخلقه أن يقسموا إلّا به.
أقول: و تقدّم في هذا المعنى رواية الكافي، عن محمّد بن مسلم عن الباقرعليهالسلام في تفسير أوّل سورة النجم.
و في الدرّ المنثور، أخرج سعيد بن المنصور و ابن المنذر عن عليّ في قوله:( وَ النَّازِعاتِ غَرْقاً ) قال: هي الملائكة تنزع أرواح الكفّار( وَ النَّاشِطاتِ نَشْطاً ) هي الملائكة تنشط أرواح الكفّار ما بين الأظفار و الجلد حتّى تخرجها( وَ السَّابِحاتِ سَبْحاً ) هي الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين بين السماء و الأرض( فَالسَّابِقاتِ سَبْقاً ) هي الملائكة يسبق بعضها بعضاً بأرواح المؤمنين إلى الله( فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً ) قال هي الملائكة تدبّر أمر العباد من السنة إلى السنة.
أقول: ينبغي أن تحمل الرواية - لو صحّت - على ذكر بعض المصاديق، و قوله:( تنشط أرواح الكفّار ما بين الأظفار و الجلد حتّى تخرجها) ضرب من التمثيل لشدّة العذاب.
و فيه، أخرج ابن أبي حاتم عن عليّ بن أبي طالب أنّ ابن الكوّاء سأله عن( فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً ) قال: الملائكة يدبّرون ذكر الرحمن و أمره.
و في تفسير القمّيّ في قوله تعالى:( يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ) قال: تنشقّ الأرض بأهلها و الرادفة الصيحة.
و فيه: في قوله:( أَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحافِرَةِ ) قال: قالت قريش: أ نرجع بعد الموت؟
و فيه: في قوله:( تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خاسِرَةٌ ) قال: قالوا هذه على حدّ الاستهزاء.
و فيه، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرعليهالسلام قوله:( أَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحافِرَةِ ) يقول: في الخلق الجديد، و أمّا قوله:( فَإِذا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ) و الساهرة الأرض كانوا في القبور فلمّا سمعوا الزجرة خرجوا من قبورهم فاستووا على الأرض.
و في اُصول الكافي، بإسناده إلى داود الرقي عن أبي عبداللهعليهالسلام في قول الله عزّوجلّ:( وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ ) ، قال: من علم أنّ الله يراه و يسمع ما يقول و يعلم ما يعمله من خير أو شرّ فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال فذلك الّذي خاف مقام ربّه و نهى النفس عن الهوى.
أقول: يؤيّد الحديث ما تقدّم من معنى الخوف من مقامه تعالى.
و فيه، بإسناده عن يحيى بن عقيل قال: قال أميرالمؤمنينعليهالسلام : إنّما أخاف عليكم الاثنين: اتّباع الهوى و طول الأمل أمّا اتّباع الهوى فإنّه يصدّ عن الحقّ و أمّا طول الأمل فينسي الآخرة.
( سورة النازعات الآيات 42 - 46)
يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ( 42 ) فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا ( 43 ) إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا ( 44 ) إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا ( 45 ) كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ( 46 )
( بيان)
تعرّض لسؤالهم عن وقت قيام الساعة و ردّ له بأنّ علمه ليس لأحد إلّا الله فقد خصّه بنفسه.
قوله تعالى: ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها ) الظاهر أنّ التعبير بيسألونك لإفادة الاستمرار فقد كان المشركون بعد ما سمعوا حديث القيامة يراجعون النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم و يسألونه أن يعيّن لهم وقتها مصرّين على ذلك و قد تكرّر في القرآن الكريم الإشارة إلى ذلك.
و المرسى مصدر ميميّ بمعنى الإثبات و الإقرار و قوله:( أَيَّانَ مُرْساها ) بيان للسؤال و المعنى يسألك هؤلاء المنكرون للساعة المستهزؤن به عن الساعة متى إثباتها و إقرارها؟ أي متى تقوم القيامة؟
قوله تعالى: ( فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها ) استفهام إنكاريّ و( فِيمَ أَنْتَ ) مبتدأ و خبر، و( مِنْ ) لابتداء الغاية، و الذكرى كثرة الذكر و هو أبلغ من الذكر على ما ذكره الراغب.
و المعنى في أيّ شيء أنت من كثرة ذكر الساعة أي ما ذا يحصل لك من العلم بوقتها من ناحية كثرة ذكرها و بسبب ذلك أي لست تعلمها بكثرة ذكرها.
أو الذكرى بمعنى حضور حقيقة معنى الشيء في القلب، و المعنى - على الاستفهام
الإنكاريّ - لست في شيء من العلم بحقيقتها و ما هي عليه حتّى تحيط بوقتها و هو أنسب من المعنى السابق.
و قيل: المعنى ليس ذكراها ممّا يرتبط ببعثتك إنّما بعثت لتنذر من يخشاها.
و قيل:( فِيمَ ) إنكار لسؤالهم، و قوله:( أَنْتَ مِنْ ذِكْراها ) استئناف و تعليل لإنكار سؤالهم، و المعنى فيم هذا السؤال إنّما أنت من ذكرى الساعة لاتّصال بعثتك بها و أنت خاتم الأنبياء، و هذا المقدار من العلم يكفيهم، و هو قولهصلىاللهعليهوآلهوسلم فيما روي:( بعثت أنا و الساعة كهاتين إن كادت لتسبقني) .
و قيل: الآية من تمام سؤال المشركين خاطبوا به النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم و المعنى ما الّذي عندك من العلم بها و بوقتها؟ أو ما الّذي حصل لك و أنت تكثر ذكرها.
و أنت خبير بأنّ السياق لا يلائم شيئاً من هذه المعاني تلك الملاءمة، على أنّها أو أكثرها لا تخلو من تكلّف.
قوله تعالى: ( إِلى رَبِّكَ مُنْتَهاها ) في مقام التعليل لقوله:( فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها ) و المعنى لست تعلم وقتها لأنّ انتهاءها إلى ربّك فلا يعلم حقيقتها و صفاتها و منها تعيّن الوقت إلّا ربّك فليس لهم أن يسألوا عن وقتها و ليس في وسعك أن تجيب عنها.
و ليس من البعيد - و الله أعلم - أن تكون الآية في مقام التعليل بمعنى آخر و هو أنّ الساعة تقوم بفناء الأشياء و سقوط الأسباب و ظهور أن لا ملك إلّا لله الواحد القهّار فلا ينتسب اليوم إلّا إليه تعالى من غير أن يتوسّط بالحقيقة بينه تعالى و بين اليوم أيّ سبب مفروض و منه الزمان فليس يقبل اليوم توقيتاً بحسب الحقيقة.
و لذا لم يرد في كلامه تعالى من التحديد إلّا تحديد اليوم بانقراض نشأة الدنيا كقوله:( وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ ) الزمر: 68 و ما في معناه من الآيات الدالّة على خراب الدنيا بتبدّل الأرض و السماء و انتثار الكواكب و غير ذلك.
و إلّا تحديده بنوع من التمثيل و التشبيه كقوله تعالى:( كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ
يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها ) و قوله:( كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا ساعَةً مِنْ نَهارٍ ) الأحقاف: 35، و قوله:( وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لَبِثُوا غَيْرَ ساعَةٍ ) ثمّ ذكر حقّ القول في ذلك فقال:( وَ قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ الْإِيمانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتابِ اللهِ إِلى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهذا يَوْمُ الْبَعْثِ ) الروم: 56.
و يلوّح إلى ما مرّ ما في مواضع من كلامه أنّ الساعة لا تأتي إلّا بغتة، قال تعالى:( ثَقُلَتْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللهِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ) الأعراف: 187 إلى غير ذلك من الآيات.
و هذا وجه عميق يحتاج في تمامه إلى تدبّر واف ليرتفع به ما يتراءى من مخالفته لظواهر عدّة من آيات القيامة و عليك بالتدبّر في قوله تعالى:( لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ) ق: 22 و ما في معناه من الآيات و الله المستعان.
قوله تعالى: ( إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها ) أي إنّما كلّفناك بإنذار من يخشى الساعة دون الإخبار بوقت قيام الساعة حتّى تجيبهم عن وقتها إذا سألوك عنه فالقصر في الآية قصر إفراد بقصر شأنهصلىاللهعليهوآلهوسلم في الإنذار و تنفي عنه العلم بالوقت و تعيينه لمن يسأل عنه.
و المراد بالخشية على ما يناسب المقام الخوف منها إذا ذكّر بها أي شأنيّة الخشية لا فعليّتها قبل الإنذار.
قوله تعالى: ( كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها ) بيان لقرب الساعة بحسب التمثيل و التشبيه بأنّ قرب الساعة من حياتهم الدنيا بحيث مثلهم حين يرونها مثلهم لو لبثوا بعد حياتهم في الأرض عشيّة أو ضحى تلك العشيّة أي وقتاً نسبته إلى نهار واحد نسبة العشيّة إلى ما قبلها منه أو نسبة الضحى إلى ما قبله منه.
و قد ظهر بما تقدّم أنّ المراد باللبث لبث ما بين الحياة الدنيا و البعث أي لبثهم في القبور لأنّ الحساب يقع على مجموع الحياة الدنيا.
و قيل: المراد به اللبث بين حين سؤالهم عن وقتها و بين البعث و فيه أنّهم إنّما يشاهدون لبثهم على هذه الصفة عند البعث و البعث الّذي هو الإحياء بعد الموت إنّما نسبته إلى الموت الّذي قبله دون مجموع الموت و بعض الحياة الّتي بين زمان السؤال عن الوقت و زمان الموت.
على أنّه لا يلائم ظواهر سائر الآيات المتعرّضة للبثهم قبل البعث كقوله تعالى( قالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ) المؤمنون: 112.
و قيل: المراد باللبث اللبث في الدنيا و هو سخيف.
( بحث روائي)
في تفسير القمّيّ:( وَ أَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى ) قال: هو العبد إذا وقف على معصية الله و قدر عليها ثمّ تركها مخافة الله و نهي الله و نهى النفس عنها فمكافاته الجنّة، قوله( يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها ) قال: متى تقوم؟ فقال الله:( إِلى رَبِّكَ مُنْتَهاها ) أي علمها عندالله، قوله( كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها ) قال: بعض يوم.
و في الدرّ المنثور، أخرج ابن أبي حاتم و ابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عبّاس قال: إنّ مشركي مكّة سألوا النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم فقالوا: متى تقوم الساعة استهزاء منهم فنزلت( يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها ) الآيات.
و فيه، أخرج البزّار و ابن جرير و ابن المنذر و الحاكم و صحّحه و ابن مردويه عن عائشة قالت: ما زال رسول الله يسأل عن الساعة حتّى اُنزل عليه( فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها إِلى رَبِّكَ مُنْتَهاها ) فلم يسأل عنها.
أقول: و رواه أيضاً عن عدّة من أصحاب الكتب عن عروة مرسلاً، و رواه أيضاً عن عدّة منهم عن شهاب بن طارق عن النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم : مثله، و السياق لا يلائم كونه
جواباً عن سؤال النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم .
و في بعض الروايات: كانت الأعراب إذا قدموا على النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم سألوه عن الساعة فينظر إلى أحدث إنسان فيهم فيقول: إن يعش هذا قرناً قامت عليكم ساعتكم: رواها في الدرّ المنثور، عن ابن مردويه عن عائشة.
و هي من التوقيت الّذي يجلّ عنه ساحة النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم و قد اُوحي إليه في كثير من السور القرآنيّة سيّما المكّيّة أنّ علم الساعة يختصّ به تعالى لا يعلمه إلّا هو و اُمر أن يجيب من سأله عن وقتها بنفي العلم به عن نفسه.
( سورة عبس مكّيّة و هي اثنان و أربعون آية)
( سورة عبس الآيات 1 - 16)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ( 1 ) أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ ( 2 ) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ ( 3 ) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ ( 4 ) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ ( 5 ) فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ( 6 ) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ( 7 ) وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ( 8 ) وَهُوَ يَخْشَىٰ ( 9 ) فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ( 10 ) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ( 11 ) فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ( 12 ) فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ( 13 ) مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ( 14 ) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ( 15 ) كِرَامٍ بَرَرَةٍ ( 16 )
( بيان)
وردت الروايات من طرق أهل السنّة أنّ الآيات نزلت في قصّة ابن اُمّ مكتوم الأعمى دخل على النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم و عنده قوم من صناديد قريش يناجيهم في أمر الإسلام فعبس النبيّ عنه فعاتبه الله تعالى بهذه الآيات و في بعض الأخبار من طرق الشيعة إشارة إلى ذلك.
و في بعض روايات الشيعة أنّ العابس المتولّي رجل من بني اُميّة كان عند النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم فدخل عليه ابن اُمّ مكتوم فعبس الرجل و قبض وجهه فنزلت الآيات: و سيوافيك تفصيل البحث عن ذلك في البحث الروائيّ التالي إن شاء الله تعالى.
و كيف كان الأمر فغرض السورة عتاب من يقدّم الأغنياء و المترفين على الضعفاء و المساكين من المؤمنين فيرفع أهل الدنيا و يضع أهل الآخرة ثمّ ينجرّ الكلام
إلى الإشارة إلى هوان أمر الإنسان في خلقه و تناهيه في الحاجة إلى تدبير أمره و كفره مع ذلك بنعم ربّه و تدبيره العظيم لأمره و تتخلّص إلى ذكر بعثه و جزائه إنذاراً و السورة مكّيّة بلا كلام.
قوله تعالى: ( عَبَسَ وَ تَوَلَّى ) أي بسر و قبض وجهه و أعرض.
قوله تعالى: ( أَنْ جاءَهُ الْأَعْمى ) تعليل لما ذكر من العبوس بتقدير لام التعليل.
قوله تعالى: ( وَ ما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرى ) حال من فاعل( عَبَسَ وَ تَوَلَّى ) و المراد بالتزكّي التطهّر بعمل صالح بعد التذكّر الّذي هو الاتّعاظ و الانتباه للاعتقاد الحقّ، و نفع الذكرى هو دعوتها إلى التزكّي بالإيمان و العمل الصالح.
و محصّل المعنى: بسر و أعرض عن الأعمى لمّا جاءه و الحال أنّه ليس يدري لعلّ الأعمى الّذي جاءه يتطهّر بصالح العمل بعد الإيمان بسبب مجيئه و تعلّمه و قد تذكّر قبل أو يتذكّر بسبب مجيئه و اتّعاظه بما يتعلّم فتنفعه الذكرى فيتطهّر.
و في الآيات الأربع عتاب شديد و يزيد شدّة بإتيان الآيتين الاُوليين في سياق الغيبة لما فيه من الإعراض عن المشافهة و الدلالة على تشديد الإنكار و إتيان الآيتين الأخيرتين في سياق الخطاب لما فيه من تشديد التوبيخ و إلزام الحجّة بسبب المواجهة بعد الإعراض و التقريع من غير واسطة.
و في التعبير عن الجائي بالأعمى مزيد توبيخ لما أنّ المحتاج الساعي في حاجته إذا كان أعمى فاقداً للبصر و كانت حاجته في دينه دعته إلى السعي فيها خشية الله كان من الحريّ أن يرحم و يخصّ بمزيد الإقبال و التعطّف لا أن ينقبض و يعرض عنه.
و قيل - بناء على كون المراد بالمعاتب هو النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم - : أنّ في التعبير عنه أوّلاً بضمير الغيبة إجلالاً له لإيهام أنّ من صدر عنه العبوس و التولّي غيرهصلىاللهعليهوآلهوسلم
لأنّه لا يصدر مثله عن مثله، و ثانياً بضمير الخطاب إجلالاً له أيضاً لما فيه من الإيناس بعد الإيحاش و الإقبال بعد الإعراض.
و فيه أنّه لا يلائمه الخطاب في قوله بعد:( أَمَّا مَنِ اسْتَغْنى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ) إلخ و العتاب و التوبيخ فيه أشدّ ممّا في قوله:( عَبَسَ وَ تَوَلَّى ) إلخ و لا إيناس فيه قطعاً.
قوله تعالى: ( أَمَّا مَنِ اسْتَغْنى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَ ما عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى ) الغنى و الاستغناء و التغنّي و التغاني بمعنى على ما ذكره الراغب فالمراد بمن استغنى من تلبّس بالغنى و لازمه التقدّم و الرئاسة و العظمة في أعين الناس و الاستكبار عن اتّباع الحقّ قال تعالى:( إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى ) العلق: 7 و التصدّي التعرّض للشيء بالإقبال عليه و الاهتمام بأمره.
و في الآية إلى تمام ستّ آيات إشارة إلى تفصيل القول في ملاك ما ذكر من العبوس و التولّي فعوتب عليه و محصّله أنّك تعتني و تقبل على من استغنى و استكبر عن اتّباع الحقّ و ما عليك ألا يزكّى و تتلهّى و تعرّض عمّن يجتهد في التزكّي و هو يخشى.
و قوله:( وَ ما عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى ) قيل:( ما ) نافية و المعنى و ليس عليك بأس أن لا يتزكّى حتّى يبعثك الحرص على إسلامه إلى الإعراض و التلهّي عمّن أسلم و الإقبال عليه.
و قيل:( ما ) للاستفهام الإنكاريّ و المعنى و أيّ شيء يلزمك إن لم يتطهّر من الكفر و الفجور فإنّما أنت رسول ليس عليك إلّا البلاغ.
و قيل: المعنى و لا تبالي بعدم تطهّره من دنس الكفر و الفجور و هذا المعنى أنسب لسياق العتاب ثمّ الّذي قبله ثمّ الّذي قبله.
قوله تعالى: ( وَ أَمَّا مَنْ جاءَكَ يَسْعى وَ هُوَ يَخْشى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ) السعي الإسراع في المشي فمعنى قوله:( وَ أَمَّا مَنْ جاءَكَ يَسْعى ) بحسب ما يفيده المقام: و أمّا من جاءك مسرعاً ليتذكّر و يتزكّى بما يتعلّم من معارف الدين.
و قوله:( وَ هُوَ يَخْشى ) أي يخشى الله و الخشية آية التذكّر بالقرآن قال تعالى:( ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشى ) طه: 3 و قال:( سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشى ) الأعلى: 10.
و قوله:( فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ) أي تتلهّى و تتشاغل بغيره و تقديم ضمير أنت في قوله:( فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ) و قوله:( فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ) و كذا الضميرين( لَهُ ) و( عَنْهُ ) في الآيتين لتسجيل العتاب و تثبيته.
قوله تعالى: ( كَلَّا إِنَّها تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ ) ( كَلَّا ) ردع عمّا عوتب عليه من العبوس و التولّي و التصدّي لمن استغنى و التلهّي عمّن يخشى.
و الضمير في( إِنَّها تَذْكِرَةٌ ) للآيات القرآنيّة أو للقرآن و تأنيث الضمير لتأنيث الخبر و المعنى أنّ الآيات القرآنيّة أو القرآن تذكرة أي موعظة يتّعظ بها من اتّعظ أو مذكّر يذكّر حقّ الاعتقاد و العمل.
و قوله:( فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ ) جملة معترضة و الضمير للقرآن أو ما يذكّر به القرآن من المعارف، و المعنى فمن شاء ذكر القرآن أو ذكر ما يذكّر به القرآن و هو الانتقال إلى ما تهدي إليه الفطرة ممّا تحفظه في لوحها من حقّ الاعتقاد و العمل.
و في التعبير بهذا التعبير:( فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ ) تلويح إلى أن لا إكراه في الدعوة إلى التذكّر فلا نفع فيها يعود إلى الداعي و إنّما المنتفع بها المتذكّر فليختر ما يختاره.
قوله تعالى: ( فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ ) قال في المجمع: الصحف جمع صحيفة، و العرب تسمّي كلّ مكتوب فيه صحيفة كما تسمّيه كتاباً رقّاً كان أو غيره انتهى.
و( فِي صُحُفٍ ) خبر بعد خبر لأنّ و ظاهره أنّه مكتوب في صحف متعدّدة بأيدي ملائكة الوحي، و هذا يضعّف القول بأنّ المراد بالصحف اللوح المحفوظ و لم يرد في كلامه تعالى إطلاق الصحف و لا الكتب و لا الألواح بصيغة الجمع على اللوح المحفوظ، و نظيره في الضعف القول بأنّ المراد بالصحف كتب الأنبياء الماضين لعدم ملاءمته لظهور قوله:( بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ) إلخ في أنّه صفة لصحف.
و قوله:( مُكَرَّمَةٍ ) أي معظّمة، و قوله:( مَرْفُوعَةٍ ) أي قدراً عندالله، و قوله:( مُطَهَّرَةٍ ) أي من قذارة الباطل و لغو القول و الشكّ و التناقض قال تعالى:( لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ ) حم السجدة: 42، و قال:( إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَ ما هُوَ بِالْهَزْلِ ) الطارق: 14 و قال:( ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ ) البقرة: 2، و قال:( وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً ) النساء: 82.
قوله تعالى: ( بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرامٍ بَرَرَةٍ ) صفة بعد صفة لصحف، و السفرة هم السفراء جمع سفير بمعنى الرسول و( كِرامٍ ) صفة لهم باعتبار ذواتهم و( بَرَرَةٍ ) صفة لهم باعتبار عملهم و هو الإحسان في الفعل.
و معنى الآيات أنّ القرآن تذكرة مكتوبة في صحف متعدّدة معظّمة مرفوعة قدراً مطهّراً من كلّ دنس و قذارة بأيدي سفراء من الملائكة كرام على ربّهم بطهارة ذواتهم بررة عنده تعالى بحسن أعمالهم.
و يظهر من الآيات أنّ للوحي ملائكة يتصدّون لحمل الصحف و إيحاء ما فيها من القرآن فهم أعوان جبريل و تحت أمره و نسبة إلقاء الوحي إليهم لا تنافي نسبته إلى جبريل في مثل قوله:( نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلى قَلْبِكَ ) الشعراء: 194 و قد قال تعالى في صفته:( إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ) التكوير: 21 فهو مطاع من الملائكة من يصدر عن أمره و يأتي بما يريده و الإيحاء الّذي هو فعل أعوانه فعله كما أنّ فعله و فعلهم جميعاً فعل الله و ذلك نظير كون التوفّي الّذي هو فعل أعوان ملك الموت فعله، و فعله و فعلهم جميعاً فعل الله تعالى، و قد تقدّمت الإشارة إلى هذا البحث مراراً.
و قيل: المراد بالسفرة الكتاب من الملائكة، و الّذي تقدّم من المعنى أجلى و قيل: المراد بهم القرّاء يكتبونها و يقرؤنها و هو كما ترى.
( بحث روائي)
في المجمع، قيل: نزلت الآيات في عبدالله بن اُمّ مكتوم و هو عبدالله بن شريح بن مالك بن ربيعة الفهريّ من بني عامر بن لؤيّ.
و ذلك أنّه أتى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم و هو يناجي عتبة بن ربيعة و أباجهل بن هشام و العبّاس بن عبد المطّلب و اُبيّاً و اُميّة بن خلف يدعوهم إلى الله و يرجو إسلامهم فقال: يا رسول الله أقرئني و علّمني ممّا علّمك الله فجعل يناديه و يكرّر النداء و لا يدري أنّه مشتغل مقبل على غيره حتّى ظهرت الكراهة في وجه رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم لقطعه كلامه و قال في نفسه: يقول هؤلاء الصناديد إنّما أتباعه العميان و العبيد فأعرض عنه و أقبل على القوم الّذين كان يكلّمهم فنزلت الآيات.
و كان رسول الله بعد ذلك يكرمه، و إذا رآه قال: مرحبا بمن عاتبني فيه ربّي، و يقول له: هل لك من حاجة؟ و استخلفه على المدينة مرّتين في غزوتين.
أقول: روى السيوطي في الدرّ المنثور القصّة عن عائشة و أنس و ابن عبّاس على اختلاف يسير و ما أورده الطبرسيّ محصّل الروايات.
و ليست الآيات ظاهرة الدلالة على أنّ المراد بها هو النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم بل خبر محض لم يصرّح بالمخبر عنه بل فيها ما يدلّ على أنّ المعنىّ بها غيره لأنّ العبوس ليس من صفات النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم مع الأعداء المباينين فضلاً عن المؤمنين المسترشدين. ثمّ الوصف بأنّه يتصدّى للأغنياء و يتلهّى عن الفقراء لا يشبه أخلاقه الكريمة كما عن المرتضى رحمه الله.
و قد عظّم الله خُلقهصلىاللهعليهوآلهوسلم إذ قال - و هو قبل نزول هذه السورة -:( وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) و الآية واقعة في سورة( ن ) الّتي اتّفقت الروايات المبيّنة لترتيب نزول السور على أنّها نزلت بعد سورة اقرأ باسم ربّك، فكيف يعقل أن يعظّم الله خلقه في
أوّل بعثته و يطلق القول في ذلك ثمّ يعود فيعاتبه على بعض ما ظهر من أعماله الخلقيّة و يذمّه بمثل التصدّي للأغنياء و إن كفروا و التلهّي عن الفقراء و إن آمنوا و استرشدوا.
و قال تعالى أيضاً:( وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) الشعراء: 215 فأمره بخفض الجناح للمؤمنين و السورة من السور المكّيّة و الآية في سياق قوله:( وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) النازل في أوائل الدعوة.
و كذا قوله:( لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ وَ لا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ) الحجر: 88 و في سياق الآية قوله:( فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ) الحجر: 94 النازل في أوّل الدعوة العلنيّة فكيف يتصوّر منهصلىاللهعليهوآلهوسلم العبوس و الإعراض عن المؤمنين و قد اُمر باحترام إيمانهم و خفض الجناح و أن لا يمدّ عينيه إلى دنيا أهل الدنيا.
على أنّ قبح ترجيح غنى الغنيّ - و ليس ملاكاً لشيء من الفضل - على كمال الفقير و صلاحه بالعبوس و الإعراض عن الفقير و الإقبال على الغنيّ لغناه قبح عقليّ مناف لكريم الخلق الإنسانيّ لا يحتاج في لزوم التجنّب عنه إلى نهي لفظيّ.
و بهذا و ما تقدّمه يظهر الجواب عمّا قيل: إنّ الله سبحانه لم ينههصلىاللهعليهوآلهوسلم عن هذا الفعل إلّا في هذا الوقت فلا يكون معصية منه إلّا بعده و أمّا قبل النهي فلا.
و ذلك أنّ دعوى أنّه تعالى لم ينهه إلّا في هذا الوقت تحكّم ممنوع، و لو سلم فالعقل حاكم بقبحه و معه ينافي صدوره كريم الخلق و قد عظّم الله خلقهصلىاللهعليهوآلهوسلم قبل ذلك إذ قال:( وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) و أطلق القول، و الخلق ملكة لا تتخلّف عن الفعل المناسب لها.
و عن الصادقعليهالسلام - على ما في المجمع - أنّها نزلت في رجل من بني اُميّة كان عند النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم فجاء ابن اُمّ مكتوم فلمّا رآه تقذّر منه و جمع نفسه و عبس و أعرض بوجهه عنه فحكى الله سبحانه ذلك و أنكره عليه.
و في المجمع، و روي عن الصادقعليهالسلام أنّه قال: كان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم إذا رأى عبدالله بن اُمّ مكتوم قال: مرحباً مرحباً و الله لا يعاتبني الله فيك أبداً، و كان يصنع به من اللّطف حتّى كان يكفّ عن النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم ممّا يفعل به.
أقول : الكلام فيه كالكلام فيما تقدّمه، و معنى قوله: حتّى أنّه كان يكفّ إلخ أنّه كان يكفّ عن الحضور عند النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم لكثرة صنيعهصلىاللهعليهوآلهوسلم به انفعالاً منه و خجلاً.
( سورة عبس الآيات 17 - 42)
قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ( 17 ) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ( 18 ) مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ( 19 ) ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ( 20 ) ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ( 21 ) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ( 22 ) كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ( 23 ) فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ( 24 ) أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ( 25 ) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ( 26 ) فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ( 27 ) وَعِنَبًا وَقَضْبًا ( 28 ) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ( 29 ) وَحَدَائِقَ غُلْبًا ( 30 ) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ( 31 ) مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ( 32 ) فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ( 33 ) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ( 34 ) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ( 35 ) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ( 36 ) لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ( 37 ) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ( 38 ) ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ( 39 ) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ( 40 ) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ( 41 ) أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ( 42 )
( بيان)
دعاء على الإنسان و تعجيب من مبالغته في الكفر بربوبيّة ربّه و إشارة إلى أمره حدوثاً و بقاءً فإنّه لا يملك لنفسه شيئاً من خلق و تدبير بل الله سبحانه هو الّذي خلقه من نطفة مهينة فقدّره ثمّ السبيل يسّره ثمّ أماته فأقبره ثمّ إذا شاء أنشره فهو سبحانه
ربّه الخالق له المدبّر لأمره مطلقاً و هو في مدى وجوده لا يقضي ما أمره به ربّه و لا يهتدي بهداه.
و لو نظر الإنسان إلى طعامه فقطّ و هو مظهر واحد من مظاهر تدبيره و غرفة من بحار رحمته رأى من وسيع التدبير و لطيف الصنع ما يبهر عقله و يدهش لبّه و وراء ذلك نعم لا تعدّ - و إن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها -.
فستره تدبير ربّه و تركه شكر نعمته عجيب و إنّ الإنسان لظلوم كفّار و سيرون تبعة شكرهم و كفرهم من السرور و الاستبشار أو الكآبة و سواد الوجه.
و الآيات - كما ترى - لا تأبى الاتّصال بما قبلها سياقاً واحداً و إن قال بعضهم أنّها نزلت لسبب آخر كما سيجيء.
قوله تعالى: ( قُتِلَ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ ) دعاء على الإنسان لما أنّ في طبعه التوغّل في اتّباع الهوى و نسيان ربوبيّة ربّه و الاستكبار عن اتّباع أوامره.
و قوله:( ما أَكْفَرَهُ ) تعجيب من مبالغة في الكفر و ستر الحقّ الصريح و هو يرى أنّه مدبّر بتدبير الله لا يملك شيئاً من تدبير أمره غيره تعالى.
فالمراد بالكفر مطلق ستر الحقّ و ينطبق على إنكار الربوبيّة و ترك العبادة و يؤيّده ما في ذيل الآية من الإشارة إلى جهات من التدبير الربوبيّ المتناسبة مع الكفر بمعنى ستر الحقّ و ترك العبادة، و قد فسّر بعضهم الكفر بترك الشكر و كفران النعمة و هو و إن كان معنى صحيحاً في نفسه لكنّ الأنسب بالنظر إلى السياق هو المعنى المتقدّم.
قال في الكشّاف:( قُتِلَ الْإِنْسانُ ) دعاء عليه و هي من أشنع دعواتهم لأنّ القتل قصارى شدائد الدنيا و فظائعها و( ما أَكْفَرَهُ ) تعجّب من إفراطه في كفران نعمة الله و لا ترى اُسلوباً أغلظ منه، و لا أخشن مسّاً، و لا أدلّ على سخط، و لا أبعد شوطاً في المذمّة مع تقارب طرفيه، و لا أجمع للّأئمة على قصر متنه، انتهى.
و قيل جملة( ما أَكْفَرَهُ ) استفهاميّة و المعنى ما هو الّذي جعله كافراً، و الوجه المتقدّم أبلغ.
قوله تعالى: ( مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ) معناه على ما يعطيه المقام من أيّ شيء خلق الله الإنسان حتّى يحقّ له أن يطغى و يستكبر عن الإيمان و الطاعة، و حذف فاعل قوله:( خَلَقَهُ ) و ما بعده من الأفعال للإشعار بظهوره فمن المعلوم بالفطرة - و قد اعترف به المشركون - أن لا خالق إلّا الله تعالى.
و الاستفهام بداعي تأكيد ما في قوله:( ما أَكْفَرَهُ ) من العجب - و العجب إنّما هو في الحوادث الّتي لا يظهر لها سبب - فاُفيد أوّلاً: أنّ من العجب إفراط الإنسان في كفره ثمّ سئل ثانياً: هل في خلقته إذ خلقه الله ما يوجب له الإفراط في الكفر فاُجيب بنفيه و أن لا حجّة له يحتجّ بها و لا عذر يعتذر به فإنّه مخلوق من ماء مهين لا يملك شيئاً من خلقته و لا من تدبير أمره في حياته و مماته و نشره، و بالجملة الاستفهام توطئة للجواب الّذي في قوله:( مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ ) إلخ.
قوله تعالى: ( مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ) تنكير( نُطْفَةٍ ) للتحقير أي من نطفة مهينة حقيرة خلقة فلا يحقّ له و أصله هذا الأصل أن يطغى بكفره و يستكبر عن الطاعة.
و قوله:( فَقَدَّرَهُ ) أي أعطاه القدر في ذاته و صفاته و أفعاله فليس له أن يتعدّى الطور الّذي قدّر له و يتجاوز الحدّ الّذي عيّن له فقد أحاط به التدبير الربوبيّ من كلّ جانب ليس له أن يستقلّ بنيل ما لم يقدّر له.
قوله تعالى: ( ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ) ظاهر السياق المقصود به نفي العذر من الإنسان في كفره و استكباره أنّ المراد بالسبيل - و قد اُطلق - السبيل إلى طاعة الله و امتثال أوامره و إن شئت فقل: السبيل إلى الخير و السعادة.
فتكون الآية في معنى دفع الدخل فإنّه إذا قيل:( مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ) أمكن أن يتوهّم السامع أنّ الخلق و التقدير إذا كانا محيطين بالإنسان من كلّ جهة كانت أفعال الإنسان لذاته و صفاته مقدّرة مكتوبة و متعلّقة لمشيّة الربوبيّة الّتي لا تتخلّف فتكون أفعال الإنسان ضروريّة الثبوت واجبة التحقّق و الإنسان مجبراً عليها فاقداً للاختيار فلا صنع للإنسان في كفره إذا كفر و لا في فسقه إذا فسق و لم
يقض ما أمره الله به و إنّما ذلك بتقديره تعالى و إرادته فلا ذمّ و لا لائمة على الإنسان و لا دعوة دينية تتعلّق به لأنّ ذلك كلّه فرع للاختيار و لا اختيار.
فدفع الشبهة بقوله:( ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ) و محصّله أنّ الخلق و التقدير لا ينافيان كون الإنسان مختاراً فيما أمر به من الإيمان و الطاعة له طريق إلى السعادة الّتي خلق لها فكلّ ميسّر لما خلق له و ذلك أنّ التقدير واقع على الأفعال الإنسانيّة من طريق اختياره، و الإرادة الربوبيّة متعلّقة بأن يفعل الإنسان بإرادته و اختياره كذا و كذا فالفعل صادر عن الإنسان باختياره و هو بما أنّه اختياريّ متعلّق للتقدير.
فالإنسان مختار في فعله مسؤل عنه و إن كان متعلّقاً للقدر، و قد تقدّم البحث عن هذا المعنى كراراً في ذيل الآيات المناسبة له في هذا الكتاب.
و قيل: المراد بتيسير السبيل تسهيل خروج الإنسان من بطن اُمّه و المعنى ثمّ سهّل للإنسان سبيل الخروج و هو جنين مخلوق من نطفة.
و قيل: المراد الهداية إلى الدين و تبيين طريق الخير و الشرّ كما قال:( وَ هَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ ) البلد: 10 و الوجه المتقدّم أوجه.
قوله تعالى: ( ثُمَّ أَماتَهُ فَأَقْبَرَهُ ) الإماتة إيقاع الموت على الإنسان، و المراد بالإقبار دفنه في القبر و إخفاؤه في بطن الأرض و هذا بالبناء على الغالب الّذي جرى عليه ديدن الناس و بهذه المناسبة نسب إليه تعالى لأنّه تعالى هو الّذي هداهم إلى ذلك و ألهمهم إيّاه فللفعل نسبة إليه كما له نسبة إلى الناس.
و قيل: المراد بالإقبار جعله ذا قبر و معنى جعله ذا قبر أمره تعالى بدفنه تكرمة له لتتوارى جيفته فلا يتأذّى بها الناس و لا يتنفّروا.
و الوجه المتقدّم أنسب لسياق الآيات المسرود لتذكير تدبيره تعالى التكويني للإنسان دون التدبير التشريعيّ الّذي عليه بناء هذا الوجه.
قوله تعالى: ( ثُمَّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ ) في المجمع: الإنشار الإحياء للتصرّف بعد الموت كنشر الثوب بعد الطيّ. انتهى، فالمراد به البعث إذا شاء الله، و فيه إشارة إلى كونه بغتة لا يعلمه غيره تعالى.
قوله تعالى: ( كَلَّا لَمَّا يَقْضِ ما أَمَرَهُ ) الّذي يعطيه السياق أنّ( كَلَّا ) ردع عن معنى سؤال يستدعيه السياق و يلوّح إليه قوله:( لَمَّا يَقْضِ ما أَمَرَهُ ) كأنّه لمّا اُشير إلى أنّ الإنسان مخلوق مدبّر له تعالى من أوّل وجوده إلى آخره من خلق و تقدير و تيسير للسبيل و إماتة و إقبار و إنشار و كلّ ذلك نعمة منه تعالى سئل فقيل: فما ذا صنع الإنسان و الحال هذه الحال و هل خضع للربوبيّة أو هل شكر النعمة فاُجيب و قيل: كلّا، ثمّ اُوضح فقيل: لمّا يقض ما أمره الله به بل كفر و عصى.
فقد ظهر ممّا تقدّم أن ضمير( يَقْضِ ) للإنسان و المراد بقضائه إتيانه بما أمر الله به، و قيل: الضمير لله تعالى و المعنى لمّا يقض الله لهذا الكافر أن يأتي بما أمره به من الإيمان و الطاعة بل إنّما أمره بما أمر إتماماً للحجّة، و هو بعيد.
و ظهر أيضاً أنّ ما في الآيات من الذمّ و اللّائمة إنّما هو للإنسان بما في طبعه من الإفراط في الكفر كما في قوله:( إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ) إبراهيم: 34 فينطبق على من تلبّس بالكفر و أفرط فيه بالعناد و منه يظهر عدم استقامة ما نقل عن بعضهم أنّ الآية على العموم في الكافر و المسلم لم يعبده أحد حقّ عبادته.
و ذلك أنّ الضمير للإنسان المذكور في صدر الآيات بما في طبعه من داعية الإفراط في الكفر و ينطبق على من تلبّس به بالفعل.
قوله تعالى: ( فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى طَعامِهِ ) متفرّع على ما تقدّم تفرّع التفصيل على الإجمال ففيه توجيه نظر الإنسان إلى طعامه الّذي يقتات به و يستمدّ منه لبقائه و هو واحد ممّا لا يحصى ممّا هيّأه التدبير الربوبيّ لرفع حوائجه في الحياة حتّى يتأمّله فيشاهد سعة التدبير الربوبيّ الّتي تدهش لبّه و تحيّر عقله، و تعلّق العناية الإلهيّة - على دقّتها و إحاطتها - بصلاح حاله و استقامة أمره.
و المراد بالإنسان - كما قيل - غير الإنسان المتقدّم المذكور في قوله:( قُتِلَ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ ) فإنّ المراد به خصوص الإنسان المبالغ في الكفر بخلاف الإنسان المذكور في هذه الآية المأمور بالنظر فإنّه عامّ شامل لكلّ إنسان، و لذلك أظهر و لم يضمر.
قوله تعالى: ( أَنَّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا - إلى قوله -وَ لِأَنْعامِكُمْ ) القراءة الدائرة( أَنَّا ) بفتح الهمزة و هو بيان تفصيليّ لتدبيره تعالى طعام الإنسان نعم هو مرحلة ابتدائيّة من التفصيل و أمّا القول المستوفى لبيان خصوصيّات النظام الّذي هيّأ له هذه الاُمور و النظام الوسيع الجاري في كل من هذه الاُمور و الروابط الكونيّة الّتي بين كلّ واحد منها و بين الإنسان فممّا لا يسعه نطاق البيان عادة.
و بالجملة قوله:( أَنَّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا ) الصبّ إراقة الماء من العلو، و المراد بصب الماء إنزال الأمطار على الأرض لإنبات النبات، و لا يبعد أن يشمل إجراء العيون و الأنهار فإنّ ما في بطن الأرض من ذخائر الماء إنّما يتكوّن من الأمطار.
و قوله:( ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ) ظاهره شقّ الأرض بالنبات الخارج منها و لذا عطف على صبّ الماء بثمّ و عطف عليه إنبات الحبّ بالفاء.
و قوله:( فَأَنْبَتْنا فِيها حَبًّا ) ضمير( فِيها) للأرض، و المراد بالحبّ جنس الحبّ الّذي يقتات به الإنسان كالحنطة و الشعير و نحوهما و كذا في العنب و القضب و غيرهما.
و قوله:( وَ عِنَباً وَ قَضْباً ) العنب معروف، و يطلق على شجر الكرم و لعلّه المراد في الآية و نظيره الزيتون.
و القضب هو الغضّ الرطب من البقول الّذي يأكله الإنسان يقضب أي يقطع مرّة بعد اُخرى، و قيل: هو ما يقطع من النبات فتعلّف به الدوابّ.
و قوله:( وَ زَيْتُوناً وَ نَخْلًا ) معروفان.
و قوله:( وَ حَدائِقَ غُلْباً ) الحدائق جمع حديقة و هي على ما فسّر البستان المحوّط و الغلب جمع غلباء يقال: شجرة غلباء أي عظيمة غليظة فالحدائق الغلب البساتين المشتملة على أشجار عظام غلاظ.
و قوله:( وَ فاكِهَةً وَ أَبًّا ) قيل: الفاكهة مطلق الثمار، و قيل: ما عدا العنب و الرّمان. قيل: إنّ ذكر ما يدخل في الفاكهة أوّلاً كالزيتون و النخل للاعتناء بشأنه
و الأبّ الكلاء و المرعى.
و قوله:( مَتاعاً لَكُمْ وَ لِأَنْعامِكُمْ ) مفعول له أي أنبتنا ما أنبتنا ممّا تطعمونه ليكون تمتيعاً لكم و للأنعام الّتي خصصتموها بأنفسكم.
و الالتفات عن الغيبة إلى الخطاب في الآية لتأكيد الامتنان بالتدبير أو بإنعام النعمة.
قوله تعالى: ( فَإِذا جاءَتِ الصَّاخَّةُ ) إشارة إلى ما ينتهي إليه ما ذكر من التدبير العامّ الربوبيّ للإنسان بما أنّ فيه أمراً ربوبيّاً إلهيّاً بالعبودية يقضيه الإنسان أوّلاً يقضيه و هو يوم القيامة الّذي يوفّى فيه الإنسان جزاء أعماله.
و الصاخة: الصيحة الشديدة الّتي تصمّ الأسماع من شدّتها، و المراد بها نفخة الصور.
قوله تعالى: ( يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَ أُمِّهِ وَ أَبِيهِ وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ ) إشارة إلى شدّة اليوم فالّذين عدّوا من أقرباء الإنسان و أخصائه هم الّذين كان يأوي إليهم و يأنس بهم و يتّخذهم أعضاداً و أنصاراً يلوذ بهم في الدنيا لكنّه يفرّ منهم يوم القيامة لما أنّ الشدّة أحاطت به بحيث لا تدعه يشتغل بغيره و يعتني بما سواه كائناً من كان فالبلبيّة إذا عظمت و اشتدّت و أطّلت على الإنسان جذبته إلى نفسها و صرفته عن كلّ شيء.
و الدليل على هذا المعنى قوله بعد:( لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ) أي يكفيه من أن يشتغل بغيره.
و قيل: في سبب فرار الإنسان من أقربائه و أخصّائه يومئذ وجوه اُخر لا دليل عليها أغمضنا عن إيرادها.
قوله تعالى: ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ) بيان لانقسام الناس يومئذ إلى قسمين: أهل السعادة و أهل الشقاء، و إشارة إلى أنّهم يعرفون بسيماهم في وجوههم و إسفار الوجه إشراقه و إضاءته فرحاً و سروراً و استبشاره تهلّله بمشاهدة ما فيه البشرى.
قوله تعالى: ( وَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْها غَبَرَةٌ ) هي الغبار و الكدورة و هي سيماء الهمّ و الغمّ.
قوله تعالى: ( تَرْهَقُها قَتَرَةٌ ) أي يعلوها و يغشاها سواد و ظلمة، و قد بيّن حال الطائفتين في الآيات الأربع ببيان حال وجوههما لأنّ الوجه مرآة القلب في سروره و مساءته.
قوله تعالى: ( أُولئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ) أي الجامعون بين الكفر اعتقاداً و الفجور و هو المعصية الشنيعة عملاً أو الكافرون بنعمة الله الفاجرون، و هذا تعريف للطائفة الثانية و هم أهل الشقاء و لم يأت بمثله في الطائفة الاُولى و هم أهل السعادة لأنّ الكلام مسوق للإنذار و الاعتناء بشأن أهل الشقاء.
( بحث روائي)
في الدرّ المنثور، أخرج ابن المنذر عن عكرمة في قوله:( قُتِلَ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ ) قال: نزلت في عتبة بن أبي لهب حين قال: كفرت بربّ النجم إذا هوى فدعا عليه النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم فأخذه الأسد بطريق الشام.
و في الاحتجاج، عن أميرالمؤمنينعليهالسلام في حديث طويل:( قُتِلَ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ ) أي لعن الإنسان.
و في تفسير القمّيّ:( ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ) قال: يسّر له طريق الخير.
أقول: المراد به جعله مختاراً في فعله يسهل به سلوكه سبيل السعادة و وصوله إلى الكمال الّذي خلق له. فالخبر منطبق على ما قدّمناه من الوجه في تفسير الآية.
و فيه،: في قوله:( وَ قَضْباً ) قال: القضب القتّ.
و فيه: في قوله:( وَ فاكِهَةً وَ أَبًّا ) قال: الأبّ الحشيش للبهائم.
و في الدرّ المنثور، أخرج أبوعبيد في فضائله عن إبراهيم التيميّ قال: سئل أبوبكر الصديق عن قوله:( وَ أَبًّا ) فقال: أيّ سماء تظلّني و أي أرض تقلّني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم.
و فيه، أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن سعد و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن مردويه و البيهقي في شعب الإيمان و الخطيب و الحاكم و صحّحه عن أنس أنّ عمر قرأ على المنبر( فَأَنْبَتْنا فِيها حَبًّا وَ عِنَباً وَ قَضْباً - إلى قوله -وَ أَبًّا ) قال: كلّ هذا قد عرفناه فما الأبّ؟ ثمّ رفض عصاً كانت في يده فقال: هذا لعمر الله هو التكلّف فما عليك أن لا تدري ما الأبّ؟ اتّبعوا ما بيّن لكم هداه من الكتاب فاعملوا به و ما لم تعرفوه فكلوه إلى ربّه.
و فيه، أخرج عبد بن حميد عن عبد الرحمن بن يزيد أنّ رجلاً سأل عمر عن قوله:( وَ أَبًّا ) فلمّا رآهم يقولون أقبل عليهم بالدرّة.
أقول: هو مبني على منعهم عن البحث عن معارف الكتاب حتّى تفسير ألفاظه.
و في إرشاد المفيد، و روي: أنّ أبابكر سئل عن قول الله تعالى:( وَ فاكِهَةً وَ أَبًّا ) فلم يعرف معنى الأبّ من القرآن فقال: أيّ سماء تظلّني أم أيّ أرض تقلّني أم كيف أصنع إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ أمّا الفاكهة فنعرفها و أمّا الأبّ فالله أعلم.
فبلغ أميرالمؤمنينعليهالسلام مقاله في ذلك فقال: سبحان الله أ ما علم أنّ الأبّ هو الكلاء و المرعى؟ و أنّ قوله تعالى:( وَ فاكِهَةً وَ أَبًّا ) اعتداد من الله بإنعامه على خلقه فيما غذّاهم به و خلقه لهم و لأنعامهم ممّا تحيى به أنفسهم و تقوم به أجسادهم.
و في المجمع، و روي عن عطاء بن يسار عن سودة زوج النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم قالت: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : يبعث الناس حفاة عراة غرلا(1) يلجمهم العرق و يبلغ شحمة الاُذن
____________________
(1) الغرل بالغين المعجمة جمع أغرل و هو الأقلف غير المختون.
قالت: قلت: يا رسول الله وا سوأتاه ينظر بعضنا إلى بعض إذا جاء؟ قال: شغل الناس عن ذلك و تلا رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ( لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ) .
و في تفسير القمّيّ: قوله:( لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ) قال: شغل يشغله عن غيره.
( سورة التكوير مكّيّة و هي تسع و عشرون آية)
( سورة التكوير الآيات 1 - 14)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ( 1 ) وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ ( 2 ) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ( 3 ) وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ( 4 ) وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ( 5 ) وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ( 6 ) وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ( 7 ) وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ( 8 ) بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ ( 9 ) وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ( 10 ) وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ( 11 ) وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ( 12 ) وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ( 13 ) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ( 14 )
( بيان)
تذكر السورة يوم القيامة بذكر بعض أشراطها و ما يقع فيها و تصفه بأنّه يوم ينكشف فيه للإنسان ما عمله من عمل ثمّ تصف القرآن بأنّه ممّا ألقاه إلى النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم رسول سماويّ و هو ملك الوحي و ليس بإلقاء شيطاني و لا أنّ النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم مجنون يمسّه الشيطان.
و يشبه أن تكون السورة من السور العتائق النازلة في أوائل البعثة كما يشهد به ما فيها من تنزيههصلىاللهعليهوآلهوسلم ممّا رموه به من الجنون و قد اتّهموه به في أوائل الدعوة و قد اشتملت على تنزيهه منه سورة( ن ) و هي من العتائق.
و السورة مكّيّة بلا كلام.
قوله تعالى: ( إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ) التكوير اللفّ على طريق الإدارة كلفّ
العمامة على الرأس، و لعلّ المراد بتكوير الشمس انظلام جرمها على نحو الإحاطة استعارة.
قوله تعالى: ( وَ إِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ) انكدار الطائر من الهواء انقضاضه نحو الأرض، و عليه فالمراد سقوط النجوم كما يفيده قوله:( وَ إِذَا الْكَواكِبُ انْتَثَرَتْ ) الانفطار: 2 و يمكن أن يكون من الانكدار بمعنى التغيّر و قبول الكدورة فيكون المراد به ذهاب ضوئها.
قوله تعالى: ( وَ إِذَا الْجِبالُ سُيِّرَتْ ) بما يصيبها من زلزلة الساعة من التسيير فتندكّ و تكون هباءً منبثّاً و تصير سراباً على ما ذكره سبحانه في مواضع من كلامه.
قوله تعالى: ( وَ إِذَا الْعِشارُ عُطِّلَتْ ) قيل: العشار جمع عشراء كالنفاس جمع نفساء و هي الناقة الحامل الّتي أتت عليها عشرة أشهر فتسمّى عشراء حتّى تضع حملها و ربّما سمّيت عشراء بعد الوضع أيضاً و هي من أنفس المال عند العرب.
و تعطيل العشار تركها مهملة لا راعي لها و لا حافظ يحفظها و كأنّ في الجملة إشارة على نحو الكناية إلى أنّ نفائس الأموال الّتي يتنافس فيها الإنسان تبقى اليوم و لا صاحب لها يتملّكها و يتصرّف فيها لأنّهم مشغولون بأنفسهم عن كلّ شيء كما قال:( لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ) عبس: 37.
قوله تعالى: ( وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ) الوحوش جمع وحش و هو من الحيوان ما لا يتأنّس بالإنسان كالسباع و غيرها.
و ظاهر الآية من حيث وقوعها في سياق الآيات الواصفة ليوم القيامة أنّ الوحوش محشورة كالإنسان، و يؤيّده قوله تعالى:( وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ) الأنعام: 38.
و أمّا تفصيل حالها بعد الحشر و ما يؤل إليه أمرها فلم يرد في كلامه تعالى و لا فيما يعتمد عليه من الأخبار ما يكشف عن ذلك نعم ربّما استفيد من قوله في آية الأنعام:
( أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ ) و قوله:( ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ ) بعض ما يتّضح به الحال في الجملة لا يخفى على الناقد المتدبّر، و ربّما قيل: إنّ حشر الوحوش من أشراط الساعة لا ممّا يقع يوم القيامة و المراد به خروجها من غاباتها و أكنانها.
قوله تعالى: ( وَ إِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ ) فسّر التسجير بإضرام النار و فسّر بالملإ و المعنى على الأوّل و إذا البحار اُضرمت ناراً، و على الثاني و إذا البحار ملئت.
قوله تعالى: ( وَ إِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ) أمّا نفوس السعداء فبنساء الجنّة قال تعالى:( لَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ ) النساء: 57، و قال:( وَ زَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ) الدخان: 54 و أمّا نفوس الأشقياء فبقرناء الشياطين قال تعالى:( احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ أَزْواجَهُمْ وَ ما كانُوا يَعْبُدُونَ ) الصافّات: 22 و قال:( وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ) الزخرف: 36.
قوله تعالى: ( وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ) الموؤدة البنت الّتي تدفن حيّة و كانت العرب تئد البنات خوفاً من لحوق العار بهم من أجلهنّ كما يشير إليه قوله تعالى:( وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ يَتَوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ أَ يُمْسِكُهُ عَلى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ ) النحل: 59.
و المسؤل بالحقيقة عن قتل الموؤدة أبوها الوائد لها لينتصف منه و ينتقم لكن عدّ المسؤل في الآية هي الموؤدة نفسها فسئلت عن سبب قتلها لنوع من التعريض و التوبيخ لقاتلها و توطئة لأن تسأل الله الانتصاف لها من قاتلها حتّى يسأل عن قتلها فيؤخذ لها منه، فالكلام نظير قوله تعالى في عيسىعليهالسلام :( وَ إِذْ قالَ اللهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَ أُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ ) المائدة: 116.
و قيل: إسناد المسؤليّة إلى الموؤدة من المجاز العقلي و المراد كونها مسؤلاً عنها نظير قوله تعالى:( إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا ) إسراء: 34.
قوله تعالى: ( وَ إِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ) أي للحساب، و الصحف كتب الأعمال.
قوله تعالى: ( وَ إِذَا السَّماءُ كُشِطَتْ ) في المجمع، الكشط القلع عن شدّة التزاق
فينطبق على طيّها كما في قوله:( وَ السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ) الزمر: 67، و قوله:( وَ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ وَ نُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزِيلًا ) الفرقان: 25 و غير ذلك من الآيات المفصحة عن هذا المعنى.
قوله تعالى: ( وَ إِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ) التسعير تهييج النار حتّى تتأجّج.
قوله تعالى: ( وَ إِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ) الإزلاف التقريب و المراد تقريبها من أهلها للدخول.
قوله تعالى: ( عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ ) جواب إذا، و المراد بالنفس الجنس و المراد بما أحضرت عملها الّذي عملته يقال: أحضرت الشيء أي وجدته حاضراً كما يقال: أحمدته أي وجدته محموداً.
فالآية في معنى قوله تعالى:( يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ ) آل عمران: 30.
( بحث روائي)
في تفسير القمّيّ:( إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ) قال: تصير سوداء مظلمة( وَ إِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ) قال: يذهب ضوؤها( وَ إِذَا الْجِبالُ سُيِّرَتْ ) قال: تسيّر كما قال:( تَحْسَبُها جامِدَةً وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ ) . قوله:( وَ إِذَا الْعِشارُ عُطِّلَتْ ) قال الإبل تتعطّل إذا مات الخلق فلا يكون من يحلبها، قوله:( وَ إِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ ) قال: تتحوّل البحار الّتي حول الدنيا كلّها نيراناً( وَ إِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ) قال: من الحور العين.
و فيه، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرعليهالسلام في قوله:( وَ إِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ) قال: أمّا أهل الجنّة فزوّجوا الخيرات الحسان، و أمّا أهل النار فمع كلّ إنسان منهم شيطان يعني قرنت نفوس الكافرين و المنافقين بالشياطين فهم قرناؤهم.
أقول: الظاهر أنّ قوله: يعني إلخ من كلام الراوي.
و في الدرّ المنثور، أخرج ابن أبي حاتم و الديلميّ عن أبي مريم أنّ النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم قال في قوله:( إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ) قال: كوّرت في جهنّم( وَ إِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ) قال: انكدرت في جهنّم، و كلّ من عبد من دون الله فهو في جهنّم إلّا ما كان من عيسى بن مريم و اُمّه و لو رضيا أن يعبدا لدخلاها.
و في تفسير القمّيّ: في قوله تعالى:( وَ إِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ) قال: صحف الأعمال قوله:( وَ إِذَا السَّماءُ كُشِطَتْ ) قال: اُبطلت.
و في الدرّ المنثور، أخرج ابن مردويه عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم يقول:( وَ إِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ) قال: هما الرجلان يعملان العمل يدخلان الجنّة و النار.
( سورة التكوير الآيات 15 - 29)
فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ( 15 ) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ( 16 ) وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ( 17 ) وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ( 18 ) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ( 19 ) ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ( 20 ) مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ( 21 ) وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ( 22 ) وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ( 23 ) وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ( 24 ) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ( 25 ) فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ( 26 ) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ( 27 ) لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ( 28 ) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ( 29 )
( بيان)
تنزيه للنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم من الجنون - و قد اتّهموه به - و لما يأتي به - من القرآن - من مداخلة الشيطان، و أنّه كلامه تعالى يلقيه إليه ملك الوحي الّذي لا يخون في رسالته، و أنّه ذكر للعالمين هاد بإذن الله لمن اهتدى منهم.
قوله تعالى: ( فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوارِ الْكُنَّسِ ) الخنّس جمع خانس كطلّب جمع طالب، و الخنوس الانقباض و التأخّر و الاستتار، و الجواري جمع جارية، و الجري السير السريع مستعار من جرى الماء، و الكنّس جمع كانس و الكنوس دخول الوحش كالظبي و الطير كناسة أي بيته الّذي اتّخذه لنفسه و استقراره فيه.
و تعقّب قوله:( فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ) إلخ بقوله:( وَ اللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ وَ الصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ ) يؤيّد كون المراد بالخنّس الجوار الكنّس الكواكب كلّها أو بعضها لكن صفات حركة بعضها أشدّ مناسبة و أوضح انطباقاً على ما ذكر من الصفات المقسم بها: الخنوس و الجري و الكنوس و هي السيّارات الخمس المتحيّرة: زحل و المشتري و المرّيخ و الزهرة و عطارد فإنّ لها في حركاتها على ما تشاهد استقامة و رجعة و إقامة فهي تسير و تجري حركة متشابهة زماناً و هي الاستقامة و تنقبض و تتأخّر و تخنس زماناً و هي الرجعة و تقف عن الحركة استقامة و رجعة زماناً كأنّها الوحش تكنس في كناسها و هي الإقامة.
و قيل: المراد بها مطلق الكواكب و خنوسها استتارها في النهار تحت ضوء الشمس و جريها سيرها المشهود في الليل و كنوسها غروبها في مغربها و تواريها.
و قيل: المراد بها بقر الوحش أو الظبي و لا يبعد أن يكون ذكر بقر الوحش أو الظبي من باب المثال و المراد مطلق الوحوش.
و كيف كان فأقرب الأقوال أوّلها و الثاني بعيد و الثالث أبعد.
قوله تعالى: ( وَ اللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ ) عطف على الخنّس، و( إِذا عَسْعَسَ ) قيد للّيل، و العسعسة تطلق على إقبال اللّيل و على إدباره قال الراغب:( وَ اللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ ) أي أقبل و أدبر و ذلك في مبدإ اللّيل و منتهاه فالعسعسة و العساس رقّة الظلام و ذلك في طرفي اللّيل. انتهى و الأنسب لاتّصال الجملة بقوله:( وَ الصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ ) أن يراد بها إدبار الليل.
و قيل: المراد بها إقبال الليل: و هو بعيد لما عرفت.
قوله تعالى: ( وَ الصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ ) عطف على الخنّس، و( إِذا تَنَفَّسَ ) قيد للصبح، و عدّ الصبح متنفّسا بسبب انبساط ضوئه على الاُفق و دفعه الظلمة الّتي غشيته نوع من الاستعارة بتشبيه الصبح و قد طلع بعد غشيان الظلام للآفاق بمن أحاطت به متاعب أعمال شاقّة ثمّ وجد خلاء من الزمان فاستراح فيه و تنفّس فعدّ
إضاءته للاُفق تنفّساً منه كذا يستفاد من بعضهم.
و ذكر الزمخشريّ فيه وجهاً آخر فقال في الكشّاف: فإن قلت: ما معنى تنفّس الصبح؟ قلت: إذا أقبل الصبح أقبل بإقباله روح و نسيم فجعل ذلك نفساً له على المجاز. انتهى و الوجه المتقدّم أقرب إلى الذهن.
قوله تعالى: ( إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ) جواب القسم، و ضمير( إِنَّهُ ) للقرآن أو لما تقدّم من آيات السورة بما أنّها قرآن بدليل قوله:( لَقَوْلُ رَسُولٍ ) إلخ و المراد بالرسول جبريل كما قال تعالى:( مَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ ) البقرة: 97.
و في إضافة القول إليه بما أنّه رسول دلالة على أنّ القول لله سبحانه، و نسبته إلى جبريل نسبة الرسالة إلى الرسول و قد وصفه الله بصفات ستّ مدحه بها.
فقوله:( رَسُولٍ ) يدلّ على رسالته و إلقائه وحي القرآن إلى النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم ، و قوله:( كَرِيمٍ ) أي ذي كرامة و عزّة عند الله بإعزازه، و قوله:( ذِي قُوَّةٍ ) أي ذي قدرة و شدّة بالغة، و قوله:( عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ) أي صاحب مكانة عند الله و المكانة القرب و المنزلة، و قوله:( مُطاعٍ ثَمَّ ) أي مطاع عند الله فهناك ملائكة يأمرهم فيطيعونه، و من هنا يظهر أنّ له أعواناً من الملائكة يأمرهم فيأتمرون بأمره، و قوله:( أَمِينٍ ) أي لا يخون فيما اُمر به يبلّغ ما حمّله من الوحي و الرسالة من غير أيّ تصرّف فيه.
و قيل: المراد بالرسول الجاري عليه الصفات هو النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم ، و هو كما ترى و لا تلائمه الآيات التالية.
قوله تعالى: ( وَ ما صاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ) عطف على قوله:( إِنَّهُ لَقَوْلُ ) إلخ وردّ لرميهم لهصلىاللهعليهوآلهوسلم بالجنون.
و في التعبير عنهصلىاللهعليهوآلهوسلم بقوله:( صاحِبُكُمْ ) تكذيب لهم في رميهم له بالجنون و تنزيه لساحته - كما قيل - ففيه إيماء إلى أنّه صاحبكم لبث بينكم معاشراً لكم
طول عمره و أنتم أعرف به قد وجدتموه على كمال من العقل و رزانة من الرأي و صدق من القول و من هذه صفته لا يرمى بالجنون.
و توصيف جبريل بما مرّ من صفات المدح دون النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم لا دلالة فيه على أفضليّته من النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم لأنّ الكلام مسوق لبيان أنّ القرآن كلام الله سبحانه منزل على النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم من عنده سبحانه من طريق الوحي لا من أوهام الجنون بإلقاء من شيطان و الّذي يفيد في هذا الغرض بيان سلامة طريق الإنزال و تجليل المنزل - اسم فاعل - بذكر أوصافه الكريمة و المبالغة في تنزيهه عن الخطإ و الخيانة، و أمّا المنزل عليه فلا يتعلّق به غرض إلّا بمقدار الإشارة إلى دفع ما يرتاب فيه من صفته و قد اُفيد بنفي الجنون الّذي رموه به و التعبير عنه بقوله:( صاحِبُكُمْ ) كما تقدّم توضيحه، كذا قيل.
و في مطاوي كلامه تعالى من نعوت النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم الكريمة ما لا يرتاب معه في أفضليّتهصلىاللهعليهوآلهوسلم على جميع الملائكة، و قد أسجد الله الملائكة كلّهم أجمعين للإنسان الّذي هو خليفته في الأرض.
قوله تعالى: ( وَ لَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ) ضمير الفاعل في( رَآهُ ) للصاحب و ضمير المفعول للرسول الكريم و هو جبريل.
و الاُفق المبين الناحية الظاهرة، و الظاهر أنّه الّذي أشار إليه بقوله:( وَ هُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلى ) النجم: 7.
و المعنى و اُقسم لقد راى النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم جبريل حال كون جبريل كائناً في الاُفق المبين و هو الاُفق الأعلى من سائر الآفاق بما يناسب عالم الملائكة.
و قيل: المعنى لقد راىصلىاللهعليهوآلهوسلم جبريل على صورته الأصليّة حيث تطلع الشمس و هو الاُفق الأعلى من ناحية المشرق.
و فيه أن لا دليل من اللفظ يدلّ عليه و خاصّة في تعلّق الرؤية بصورته الأصليّة و رؤيته في أيّ مثال تمثّل به رؤيته، و كأنّه مأخوذ ممّا ورد في بعض الروايات أنّه
رآه في أوّل البعثة و هو بين السماء و الأرض جالس على كرسيّ، و هو محمول على التمثّل.
قوله تعالى: ( وَ ما هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ) الضمير للنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم ، و المراد بالغيب الوحي النازل عليه، و الضنين صفة مشبهة من الضّنّ بمعنى البخل يعني أنّهصلىاللهعليهوآلهوسلم لا يبخل بشيء ممّا يوحى إليه فلا يكتمه و لا يحبسه و لا يغيّره بتبديل بعضه أو كلّه شيئاً آخر بل يعلّم الناس كما علّمه الله و يبلّغهم ما اُمر بتبليغه.
قوله تعالى: ( وَ ما هُوَ بِقَوْلِ شَيْطانٍ رَجِيمٍ ) نفي لاستناد القرآن إلى إلقاء شيطان بما هو أعمّ من طريق الجنون فإنّ الشيطان بمعنى الشرير و الشيطان الرجيم كما اُطلق في كلامه تعالى على إبليس و ذرّيّته كذلك اُطلق على أشرار سائر الجنّ قال تعالى:( قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ) ص: 77، و قال:( وَ حَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ ) الحجر: 17.
فالمعنى أنّ القرآن ليس بتسويل من إبليس و جنوده و لا بإلقاء من أشرار الجنّ كما يلقونه على المجانين.
قوله تعالى: ( فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ) أوضح سبحانه في الآيات السبع المتقدّمة ما هو الحقّ في أمر القرآن دافعاً عنه ارتيابهم فيه بما يرمون به الجائي به من الجنون و غيره على إيجاز متون الآيات فبيّن أوّلاً أنّه كلام الله و اتّكاء هذه الحقيقة على آيات التحدّي، و ثانياً أنّ نزوله برسالة ملك سماويّ جليل القدر عظيم المنزلة و هو أمين الوحي جبريل لا حاجز بينه و بين الله و لا بينه و بين النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم ، و لا صارف من نفسه أو غيره يصرفه عن أخذه و لا حفظه و لا تبليغه، و ثالثاً أنّ الّذي اُنزل عليه و هو يتلوه لكم و هو صاحبكم الّذي لا يخفى عليكم حاله ليس بمجنون كما يبهتونه به و قد راى الملك الحامل للوحي و أخذ عنه و ليس بكاتم لما يوحى إليه و لا بمغيّر، و رابعاً أنّه ليس بتسويل من إبليس و جنوده و لا بإلقاء من بعض أشرار الجنّ.
و نتيجة هذا البيان أنّ القرآن كتاب هدى يهتدي به من أراد الاستقامة على
الحقّ و هو قوله:( إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ ) إلخ.
فقوله:( فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ) توطئة و تمهيد لذكر نتيجة البيان السابق، و هو استضلال لهم فيما يرونه في أمر القرآن الكريم أنّه من طواري الجنون أو من تسويلات الشيطان الباطلة.
فالاستفهام في الآية توبيخيّ و المعنى إذا كان الأمر على هذا فأين تذهبون و تتركون الحقّ وراءكم؟
قوله تعالى: ( إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ ) أي تذكرة لجماعات الناس كائنين من كانوا يمكنهم بها أن يتبصّروا للحقّ، و قد تقدّم بعض الكلام في نظيرة الآية.
قوله تعالى: ( لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ) بدل من قوله:( لِلْعالَمِينَ ) مسوق لبيان أنّ فعليّة الانتفاع بهذا الذكر مشروط بأن يشاؤا الاستقامة على الحقّ و هو التلبّس بالثبات على العبوديّة و الطاعة.
قوله تعالى: ( وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ ) تقدّم الكلام في معناه في نظائر الآية.
و الآية بحسب ما يفيده السياق في معنى دفع الدخل فإنّ من الممكن أن يتوهّموا من قوله:( لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ) أنّ لهم الاستقلال في مشيّة الاستقامة إن شاؤا استقاموا و إن لم يشاؤا لم يستقيموا، فللّه إليهم حاجة في الاستقامة الّتي يريدها منهم.
فدفع ذلك بأنّ مشيّتهم متوقّفة على مشيّة الله سبحانه فلا يشاؤن الاستقامة إلّا أن يشاء الله أن يشاؤها، فأفعال الإنسان الإراديّة مرادة لله تعالى من طريق إرادته و هو أن يريد الله أن يفعل الإنسان فعلاً كذا و كذا عن إرادته.
( بحث روائي)
في الدرّ المنثور، أخرج سعيد بن منصور و الفاريابيّ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبي حاتم و الحاكم و صحّحه من طرق عن عليّ في قوله:( فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ) قال: هي الكواكب تكنس باللّيل و تخنس بالنهار فلا ترى.
و في تفسير القمّيّ: في قوله:( فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ) قال: أي و اُقسم بالخنّس و هو اسم النجوم.( الْجَوارِ الْكُنَّسِ ) قال: النجوم تكنس بالنهار فلا تبين.
و في المجمع:( بِالْخُنَّسِ ) و هي النجوم تخنس بالنهار و تبدو باللّيل( و الْجَوارِِ ) صفة لها لأنّها تجري في أفلاكها( الْكُنَّسِ ) من صفتها أيضاً لأنّها تكنس أي تتوارى في بروجها كما تتوارى الظباء في كناسها. و هي خمسة أنجم: زحل و المشتري و المرّيخ و الزهرة و عطارد عن عليّ( وَ اللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ ) أي إذا أدبر بظلامه عن عليّ.
و في تفسير القمّيّ:( وَ اللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ ) قال: إذا أظلم( و الصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسََ ) قال: إذا ارتفع.
و في الدرّ المنثور، أخرج ابن عساكر عن معاوية بن قرّة قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم لجبريل: ما أحسن ما أثنى عليك ربّك: ذي قوّة عند ذي العرش مكين مطاع ثمّ أمين فما كانت قوّتك؟ و ما كانت أمانتك؟
قال: أمّا قوّتي فإنّي بعثت إلى مدائن لوط و هي أربع مدائن، و في كلّ مدينة أربع مائة ألف مقاتل سوى الذراري فحملتهم من الأرض السفلى حتّى سمع أهل السماء أصوات الدجاج و نباح الكلاب ثمّ هويت بهم فقتلتهم، و أمّا أمانتي فلم اُؤمر بشيء فعدوته إلى غيره.
أقول: و الرواية لا تخلو من شيء و قد ضعّفوا ابن عساكر و خاصّة فيما تفرّد به.
و في الخصال، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: من قال في كلّ يوم من شعبان سبعين
مرّة: أستغفر الله الّذي لا إله إلّا هو الرحمن الرحيم الحيّ القيّوم و أتوب إليه، كتب في الاُفق المبين. قال: قلت: و ما الاُفق المبين؟ قال: قاع بين يدي العرش فيه أنهار تطّرد و فيه من القدحان عدد النجوم.
و في تفسير القمّيّ، في حديث أسنده إلى أبي عبداللهعليهالسلام : قوله:( وَ ما هُوَ بِقَوْلِ شَيْطانٍ رَجِيمٍ ) قال: يعني الكهنة الّذين كانوا في قريش فنسب كلامهم إلى كلام الشياطين الّذين كانوا معهم يتكلّمون على ألسنتهم فقال:( وَ ما هُوَ بِقَوْلِ شَيْطانٍ رَجِيمٍ ) مثل اُولئك.
( سورة الانفطار مكّيّة و هي تسع عشرة آية)
( سورة الانفطار الآيات 1 - 19)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ ( 1 ) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ ( 2 ) وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ( 3 ) وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ( 4 ) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ( 5 ) يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ( 6 ) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ( 7 ) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ( 8 ) كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ( 9 ) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ( 10 ) كِرَامًا كَاتِبِينَ ( 11 ) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ( 12 ) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ( 13 ) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ( 14 ) يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ( 15 ) وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ( 16 ) وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ( 17 ) ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ( 18 ) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ ( 19 )
( بيان)
تحدّ السورة يوم القيامة ببعض أشراطه الملازمة له المتّصلة به و تصفه بما يقع فيه و هو ذكر الإنسان ما قدّم و ما أخّر من أعماله الحسنة و السيّئة - على أنّها محفوظة عليه بواسطة حفظة الملائكة الموكّلين - عليه و جزاؤه بعمله إن كان برّاً فبنعيم و إن كان فاجراً مكذّباً بيوم الدين فبجحيم يصلاها مخلّداً فيها.
ثمّ يستأنف وصف اليوم بأنّه يوم لا يملك نفس لنفس شيئاً و الأمر يومئذ لله، و هي من غرر الآيات، و السورة مكّيّة بلا كلام.
قوله تعالى: ( إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ ) الفطر الشقّ و الانفطار الانشقاق و الآية كقوله:( وَ انْشَقَّتِ السَّماءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ واهِيَةٌ ) الحاقّة: 16.
قوله تعالى: ( وَ إِذَا الْكَواكِبُ انْتَثَرَتْ ) أي تفرّقت بتركها مواضعها الّتي ركزت فيها شبّهت الكواكب بلآلي منظومة قطع سلكها فانتثرت و تفرّقت.
قوله تعالى: ( وَ إِذَا الْبِحارُ فُجِّرَتْ ) قال في المجمع: التفجير خرق بعض مواضع الماء إلى بعض التكثير، و منه الفجور لانخراق صاحبه بالخروج إلى كثير من الذنوب، و منه الفجر لانفجاره بالضياء، انتهى. و إليه يرجع تفسيرهم لتفجير البحار بفتح بعضها في بعض حتّى يزول الحائل و يختلط العذب منها و المالح و يعود بحراً واحداً، و هذا المعنى يناسب تفسير قوله:( وَ إِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ ) التكوير: 6 بامتلاء البحار.
قوله تعالى: ( وَ إِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ) قال في المجمع، بعثرت الحوض و بحثرته إذا جعلت أسفله أعلاه، و البعثرة و البحثرة إثارة الشيء بقلب باطنه إلى ظاهره، انتهى. فالمعنى و إذا قلب تراب القبور و اُثير باطنها إلى ظاهرها لإخراج الموتى و بعثهم للجزاء.
قوله تعالى: ( عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَ أَخَّرَتْ ) المراد بالعلم علمها التفصيليّ بأعمالها الّتي عملتها في الدنيا، و هذا غير ما يحصل لها من العلم بنشر كتاب أعمالها لظاهر قوله تعالى:( بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَ لَوْ أَلْقى مَعاذِيرَهُ ) القيامة: 15 و قوله:( يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ ما سَعى ) النازعات: 35، و قوله:( يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ ) آل عمران: 30.
و المراد بالنفس جنسها فتفيد الشمول، و المراد بما قدّمت و ما أخّرت هو ما قدّمته ممّا عملته في حياتها، و بما أخّرت ما سنّته من سنّة حسنة أو سيّئة فعملت بها بعد موتها فتكتب صحيفة عملها قال تعالى:( وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ ) يس: 12.
و قيل: المراد بما قدّمت و أخّرت ما عملته في أوّل العمر و ما عملته في آخره فيكون كناية عن الاستقصاء.
و قيل في معنى التقديم و التأخير وجوه اُخر لا يعبأ بها مذكورة في مطوّلات التفاسير من أراد الوقوف عليها فليراجعها.
و قد تقدّم في تفسير قوله تعالى:( لِيَمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ) الأنفال: 37، كلام لا يخلو من نفع ههنا.
قوله تعالى: ( يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ - إلى قوله -رَكَّبَكَ ) عتاب و توبيخ للإنسان، و المراد بهذا الإنسان المكذّب ليوم الدين - على ما يفيده السياق - المشتمل على قوله:( بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ) و في تكذيب يوم الدين كفر و إنكار لتشريع الدين و في إنكاره إنكار لربوبيّة الربّ تعالى، و إنّما وجّه الخطاب إليه بما أنّه إنسان ليكون حجّة أو كالحجّة لثبوت الخصال الّتي يذكرها من نعمه عليه المختصّة من حيث المجموع بالإنسان.
و قد علّق الغرور بصفتي ربوبيّته و كرمه تعالى ليكون ذلك حجّة في توجّه العتاب و التوبيخ فإنّ تمرّد المربوب و توغّله في معصية ربّه الّذي يدبّر أمره و يغشيه نعمه ظاهرة و باطنة كفران لا ترتاب الفطرة السليمة في قبحه و لا في استحقاق العقاب عليه و خاصّة إذا كان الربّ المنعم كريماً لا يريد في نعمه و عطاياه نفعاً ينتفع به و لا عوضاً يقابله به المنعم عليه، و يسامح في إحسانه و يصفح عمّا يأتي به المربوب من الخطيئة و الإثم بجهالة فإنّ الكفران حينئذ أقبح و أقبح و توجّه الذمّ و اللّائمة أشدّ و أوضح.
فقوله تعالى:( يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ) استفهام توبيخيّ يوبّخ الإنسان بكفران خاصّ لا عذر له يعتذر به عنه و هو كفران نعمة ربّ كريم.
و ليس للإنسان أن يجيب فيقول: أي ربّ غرّني كرمك فقد قضى الله سبحانه فيما قضى و بلّغه بلسان أنبيائه:( لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي
لَشَدِيدٌ ) إبراهيم: 7، و قال:( فَأَمَّا مَنْ طَغى وَ آثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوى ) النازعات: 39، إلى غير ذلك من الآيات الناصّة في أن لا مخلص للمعاندين من العذاب و أنّ الكرم لا يشملهم يوم القيامة قال:( وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُها لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ) الأعراف: 156.
و لو كفى الإنسان العاصي قوله:( غرني كرمك) لصرف العذاب عن الكافر المعاند كما يصرفه عن المؤمن العاصي، و لا عذر بعد البيان.
و من هنا يظهر أن لا محلّ لقول بعضهم: إنّ توصيف الربّ بالكريم من قبيل تلقين الحجّة و هو من الكرم أيضاً.
كيف؟ و السياق سياق الوعيد و الكلام ينتهي إلى مثل قوله:( وَ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَها يَوْمَ الدِّينِ وَ ما هُمْ عَنْها بِغائِبِينَ ) .
و قوله:( الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ) بيان لربوبيّته المتلبّسة بالكرم فإنّ من تدبيره خلق الإنسان بجمع أجزاء وجوده ثمّ تسويته بوضع كلّ عضو فيما يناسبه من الموضع على ما يقتضيه الحكمة ثمّ عدله بعدل بعض أعضائه و قواه ببعض بجعل التوازن و التعادل بينها فما يضعف عنه عضو يقوى عليه عضو فيتمّ به فعله كما أنّ الأكل مثلاً بالالتقام و هو للفم، و يضعف الفم عن قطع اللقمة و نهشها و طحنها فيتمّ ذلك بمختلف الأسنان، و يحتاج ذلك إلى نقل اللقمة من جانب من الفم إلى آخر و قلبها من حال إلى حال فجعل ذلك للّسان ثمّ الفم يحتاج في فعل الأكل إلى وضع الغذاء فيه فتوصّل إلى ذلك باليد و تمّم عملها بالكفّ و عملها بالأصابع على اختلاف منافعها و عملها بالأنامل، و تحتاج اليد في الأخذ و الوضع إلى الانتقال المكانيّ نحو الغذاء و عدل ذلك بالرجل.
و على هذا القياس في أعمال سائر الجوارح و القوى و هي اُلوف و اُلوف لا يحصيها العدّ، و الكلّ من تدبيره تعالى و هو المفيض لها من غير أن يريد بذلك انتفاعاً لنفسه و من غير أن يمنعه من إفاضتها ما يقابله به الإنسان من نسيان الشكر و كفران النعمة فهو تعالى ربّه الكريم.
و قوله:( فِي أَيِّ صُورَةٍ ما شاءَ رَكَّبَكَ ) بيان لقوله:( فَعَدَلَكَ ) و لذا لم يعطف على ما تقدّمه و الصورة ما ينتقش به الأعيان و يتميّز به الشيء من غيره و( ما ) زائدة للتأكيد.
و المعنى: في أيّ صورة شاء أن يركّبك - و لا يشاء إلّا ما تقتضيه الحكمة - ركّبك من ذكر و اُنثى و أبيض و أسود و طويل و قصير و وسيم و دميم و قويّ و ضعيف إلى غير ذلك و كذا الأعضاء المشتركة بين أفراد الإنسان المميّزة لها من غيرها كاليدين و الرجلين و العينين و الرأس و البدن و استواء القامة و نحوها فكلّ ذلك من عدل بعض الأجزاء ببعض في التركيب قال تعالى:( لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ) التين: 4 و الجميع ينتهي إلى تدبير الربّ الكريم لا صنع للإنسان في شيء من ذلك.
قوله تعالى: ( كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ) ( كَلَّا ) ردع عن اغترار الإنسان بكرم الله و جعل ذلك ذريعة إلى الكفر و المعصية أي لا تغترّوا فلا ينفعكم الاغترار.
و قوله:( بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ) أي بالجزاء. إضراب عمّا يفهم من قوله:( ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ) من غرور الإنسان بربّه الكريم على اعتراف منه و لو بالقوّة بالجزاء لقضاء الفطرة السليمة به.
فإذ عاتب الإنسان و وبّخه على غروره بربّه الكريم و اجترائه على الكفران و المعصية من غير أن يخاف الجزاء أضرب عنه مخاطباً للإنسان و كلّ من يشاركه في كفره و معصيته فقال: بل أنت و من حاله حالك تكذّبون بيوم الدين و الجزاء فتجحدونه ملحّين عليه.
قوله تعالى: ( وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ كِراماً كاتِبِينَ يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ ) إشارة إلى أنّ أعمال الإنسان حاضرة محفوظة يوم القيامة من طريق آخر غير حضورها للإنسان العامل لها من طريق الذكر و ذلك حفظها بكتابة كتاب الأعمال من الملائكة الموكّلين بالإنسان فيحاسب عليها كما قال تعالى:( وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً اقْرَأْ كِتابَكَ كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً ) إسراء: 14.
فقوله:( وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ ) أي إنّ عليكم من قبلنا حافظين يحفظون
أعمالكم بالكتابة كما يفيده السياق.
و قوله:( كِراماً كاتِبِينَ ) أي اُولي كرامة و عزّة عند الله تعالى و قد تكرّر في القرآن الكريم وصف الملائكة بالكرامة و لا يبعد أن يكون المراد به بإعانة من السياق كونهم بحسب الخلقة مصونين عن الإثم و المعصية مفطورين على العصمة، و يؤيّده قوله:( بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ) الأنبياء: 26 حيث دلّ على أنّهم لا يريدون إلّا ما أراده الله و لا يفعلون إلّا ما أمرهم به، و كذا قوله:( كِرامٍ بَرَرَةٍ ) عبس 16.
و المراد بالكتابة في قوله:( كاتِبِينَ ) كتابة الأعمال بقرينة قوله:( يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ ) و قد تقدّم في تفسير قوله:( إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) الجاثية: 29 كلام في معنى كتابة الأعمال فليراجعه من شاء.
و قوله:( يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ ) نفي لخطئهم في تشخيص الخير و الشرّ و تمييز الحسنة و السيّئة كما أنّ الآية السابقة متضمّنة لتنزيههم عن الإثم و المعصية فهم محيطون بالأفعال على ما هي عليه من الصفة و حافظون لها على ما هي عليه.
و لا تعيين في هذه الآيات لعدّة هؤلاء الملائكة الموكّلين على كتابة أعمال الإنسان نعم المستفاد من قوله تعالى:( إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيانِ عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ ) ق: 17 أنّ على كلّ إنسان منهم اثنين عن يمينه و شماله، و قد ورد في الروايات المأثورة أنّ الّذي على اليمين كاتب الحسنات و الّذي على الشمال كاتب السيّئات.
و ورد أيضاً في تفسير قوله:( إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً ) إسراء: 78 أخبار مستفيضة من طرق الفريقين دالّة على أنّ كتبة الأعمال بالنهار يصعدون بعد غروب الشمس و ينزل آخرون فيكتبون أعمال اللّيل حتّى إذا طلع الفجر صعدوا و نزل ملائكة النهار و هكذا.
و في الآية أعني قوله:( يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ ) دلالة على أنّ الكتبة عالمون بالنيّات إذ لا طريق إلى العلم بخصوصيّات الأفعال و عناوينها و كونها خيراً أو شرّاً أو حسنة أو سيّئة إلّا العلم بالنيّات فعلمهم بالأفعال لا يتمّ إلّا عن العلم بالنيّات.
قوله تعالى: ( إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ وَ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ) استئناف مبيّن لنتيجة حفظ الأعمال بكتابة الكتبة و ظهورها يوم القيامة.
و الأبرار هم المحسنون عملاً، و الفجّار هم المنخرقون بالذنوب و الظاهر أنّ المراد بهم المتهتّكون من الكفّار إذ لا خلود لمؤمن في النار، و في تنكير( نعيم ) و( جحيم ) إشعار بالتفخيم و التهويل - كما قيل -.
قوله تعالى: ( يَصْلَوْنَها يَوْمَ الدِّينِ ) الضمير للجحيم أي يلزمون يعني الفجّار الجحيم يوم الجزاء و لا يفارقونها.
قوله تعالى: ( وَ ما هُمْ عَنْها بِغائِبِينَ) عطف تفسيري على قوله:( يَصْلَوْنَها ) إلخ يؤكّد معنى ملازمتهم للجحيم و خلودهم في النار، و المراد بغيبتهم عنها خروجهم منها فالآية في معنى قوله:( وَ ما هُمْ بِخارِجِينَ مِنَ النَّارِ ) البقرة: 167.
قوله تعالى: ( وَ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ ) تهويل و تفخيم لأمر يوم الدين، و المعنى لا تحيط علماً بحقيقة يوم الدين و هذا التعبير كناية عن فخامة أمر الشيء و علوّه من أن يناله وصف الواصف، و في إظهار اليوم - و المحلّ محلّ الضمير - تأكيد لأمر التفخيم.
قوله تعالى: ( ثُمَّ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ ) في تكرار الجملة تأكيد للتفخيم.
قوله تعالى:( يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ) الظرف منصوب بتقدير اذكر و نحوه، و في الآية بيان إجماليّ لحقيقة يوم الدين بعد ما في قوله:( وَ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ ) من الحثّ على معرفته.
و ذلك أنّ رابطة التأثير و التأثّر بين الأسباب الظاهريّة و مسبّباتها منقطعة زائلة يومئذ كما يستفاد من أمثال قوله تعالى:( وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبابُ ) البقرة: 166، و قوله:( وَ لَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً ) البقرة: 165 فلا تملك نفس لنفس شيئاً فلا تقدر على دفع شرّ عنها و لا جلب خير لها، و لا ينافي ذلك آيات الشفاعة لأنّها بإذن الله فهو المالك لها لا غير.
و قوله:( وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ) أي هو المالك للأمر ليس لغيره من الأمر شيء.
و المراد بالأمر كما قيل واحد الأوامر لقوله تعالى:( لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ ) المؤمن: 16 و شأن الملك المطاع، الأمر بالمعنى المقابل للنهي، و الأمر بمعنى الشأن لا يلائم المقام تلك الملاءمة.
( بحث روائي)
في تفسير القمّيّ: في قوله تعالى:( وَ إِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ) قال: تنشقّ فتخرج الناس منها.
و في الدرّ المنثور، أخرج الحاكم و صحّحه عن حذيفة قال: قال النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم : من استنّ خيراً فاستنّ به فله أجره و مثل اُجور من اتّبعه غير منتقص من اُجورهم و من استنّ شرّاً فاستنّ به فله وزره و مثل أوزار من اتّبعه غير منتقص من أوزارهم، و تلا حذيفة( عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَ أَخَّرَتْ ) .
و فيه، أخرج عبد بن حميد عن صالح بن مسمار قال: بلغني أنّ النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم تلا هذه الآية( يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ) ثمّ قال: جهله.
و في تفسير القمّيّ:( فِي أَيِّ صُورَةٍ ما شاءَ رَكَّبَكَ ) قال: لو شاء ركّبك على غير هذه الصورة.
أقول: و رواه في المجمع، عن الصادقعليهالسلام مرسلاً.
و فيه،:( وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ ) قال: الملكان الموكّلان بالإنسان.
و عن سعد السعود، و في رواية: إنّهما - يعني الملكين الموكّلين - يأتيان المؤمن عند حضور صلاة الفجر فإذا هبطا صعد الملكان الموكّلان باللّيل فإذا غربت الشمس نزل إليه الموكّلان بكتابة اللّيل، و يصعد الملكان الكاتبان بالنهار بديوانه إلى الله عزّوجلّ.
فلا يزال ذلك دأبهم إلى وقت حضور أجله فإذا حضر أجله قالا للرجل الصالح: جزاك الله من صاحب عنّا خيراً فكم من عمل صالح أريتناه، و كم من قول حسن أسمعتناه، و كم من مجلس خير أحضرتناه فنحن اليوم على ما تحبّه و شفعاء إلى
ربّك، و إن كان عاصياً قالا له: جزاك الله من صاحب عنّا شرّاً فلقد كنت تؤذينا فكم من عمل سيّيء أريتناه، و كم من قول سيّيء أسمعتناه، و( كم ) من مجلس سوء أحضرتناه و نحن اليوم لك على ما تكره، و شهيدان عند ربّك.
و في المجمع: في قوله تعالى:( وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ) روى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفرعليهالسلام أنّه قال: الأمر يومئذ و اليوم كلّه لله. يا جابر إذا كان يوم القيامة بادت الحكّام فلم يبق حاكم إلّا الله.
أقول: مرادهعليهالسلام أنّ كون الأمر لله لا يختصّ بيوم القيامة بل الأمر لله دائماً، و تخصيصه بيوم القيامة باعتبار ظهوره لا باعتبار أصله فالّذي يختصّ به ظهور هذه الحقيقة ظهور عيان فيسقط اليوم أمر غيره تعالى و حكمه، و نظير الأمر سائر ما عدّ في كلامه تعالى من مختصّات يوم القيامة، فالرواية من غرر الروايات.
( سورة المطفّفين مكّيّة أو مدنيّة و هي ستّ و ثلاثون آية)
( سورة المطفّفين الآيات 1 - 21)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ( 1 ) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ( 2 ) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ( 3 ) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ( 4 ) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ( 5 ) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ( 6 ) كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ( 7 ) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ( 8 ) كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ( 9 ) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ( 10 ) الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ( 11 ) وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ( 12 ) إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ( 13 ) كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ( 14 ) كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ( 15 ) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ( 16 ) ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ( 17 ) كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ( 18 ) وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ( 19 ) كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ( 20 ) يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ( 21 )
( بيان)
تفتتح السورة بوعيد أهل التطفيف في الكيل و الوزن و تنذرهم بأنّهم مبعوثون للجزاء في يوم عظيم و هو يوم القيامة ثمّ تتخلّص لتفصيل ما يجري يومئذ على الفجّار و الأبرار.
و الأنسب بالنظر إلى السياق أن يكون أوّل السورة المشتمل على وعيد المطفّفين نازلاً بالمدينة و أمّا ما يتلوه من الآيات إلى آخر السورة فيقبل الانطباق على السياقات المكّيّة و المدنيّة.
قوله تعالى: ( وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ) دعاء على المطفّفين و التطفيف نقص المكيال و الميزان، و قد نهى الله تعالى عنه و سمّاه إفساداً في الأرض كما فيما حكاه من قول شعيب:( وَ يا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيالَ وَ الْمِيزانَ بِالْقِسْطِ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ) هود: 84، و قد تقدّم الكلام في تفسير الآية في معنى كونه إفساداً في الأرض.
قوله تعالى: ( الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَ إِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ) الاكتيال من الناس الأخذ منهم بالكيل، و تعديته بعلى لإفادة معنى الضرر، و الكيل إعطاؤهم بالمكيال يقال: كاله طعامه و وزنه و كال له طعامه و وزن له و الأوّل لغة أهل الحجاز و عليه التنزيل و الثاني لغة غيرهم كما في المجمع، و الاستيفاء أخذ الحقّ تامّاً كاملاً، و الإخسار الإيقاع في الخسارة.
و المعنى: الّذين إذا أخذوا من الناس بالكيل يأخذون حقّهم تامّاً كاملاً، و إذا أعطوا الناس بالكيل أو الوزن ينقصون فيوقعونهم في الخسران.
فمضمون الآيتين جميعاً ذمّ واحد و هو أنّهم يراعون الحقّ لأنفسهم و لا يراعونه لغيرهم و بعبارة اُخرى لا يراعون لغيرهم من الحقّ مثل ما يراعونه لأنفسهم و فيه إفساد الاجتماع الإنسانيّ المبنيّ على تعادل الحقوق المتقابلة و في إفساده كلّ الفساد.
و لم يذكر الاتّزان مع الاكتيال كما ذكر الوزن مع الكيل إذ قال:( وَ إِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ ) قيل: لأنّ المطفّفين كانوا باعة و هم كانوا في الأغلب يشترون الكثير من الحبوب و البقول و نحوهما من الأمتعة ثمّ يكسبون بها فيبيعونها يسيراً يسيراً تدريجاً، و كان دأبهم في الكثير من هذه الأمتعة أن يؤخذ و يعطى بالكيل لا بالوزن فذكر الاكتيال وحده في الآية مبنيّ على الغالب.
و قيل: لم يذكر الاتّزان لأنّ الكيل و الوزن بهما البيع و الشراء فذكر
أحدهما يدلّ على الآخر. و فيه أنّ ما ذكر في الاكتيال جار في الكيل أيضاً و قد ذكر معه الوزن فالوجه لا يخلو من تحكّم.
و قيل: الآيتان تحاكيان ما كان عليه دأب الّذين نزلت فيهم السورة فقد كانوا يشترون بالاكتيال فقط و يبيعون بالكيل و الوزن جميعاً، و هذا الوجه دعوى من غير دليل.
إلى غير ذلك ممّا ذكروه في توجيه الاقتصار على ذكر الاكتيال في الآية، و لا يخلو شيء منها من ضعف.
قوله تعالى: ( أَ لا يَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ) الاستفهام للإنكار و التعجيب، و الظنّ بمعناه المعروف و الإشارة إلى المطفّفين باُولئك الموضوعة للإشارة البعيدة للدلالة على بعدهم من رحمة الله، و اليوم العظيم يوم القيامة الّذي يجازون فيه بعملهم.
و الاكتفاء بظنّ البعث و حسبانه - مع أنّ من الواجب الاعتقاد العلميّ بالمعاد - لأنّ مجرّد حسبان الخطر و الضرر في عمل يوجب التجنّب عنه و التحرّز عن اقترافه و إن لم يكن هناك علم فالظنّ بالبعث ليوم عظيم يؤاخذ الله فيه الناس بما كسبوا من شأنه أن يردعهم عن اقتراف هذا الذنب العظيم الّذي يستتبع العذاب الأليم.ليم.
و قيل: الظنّ في الآية بمعنى العلم.
قوله تعالى: ( يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ ) المراد به قيامهم من قبورهم - كناية عن تلبّسهم بالحياة بعد الممات - لحكمه تعالى و قضائه بينهم.
قوله تعالى: ( كَلَّا إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَ ما أَدْراكَ ما سِجِّينٌ كِتابٌ مَرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ) ردع - كما قيل - عمّا كانوا عليه من التطفيف و الغفلة عن البعث و الحساب.
و قوله:( إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ) إلخ الّذي يعطيه التدبّر في سياق
الآيات الأربع بقياس بعضها إلى بعض و قياس المجموع إلى مجموع قوله:( كَلَّا إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ) إلى تمام أربع آيات أنّ المراد بسجّين ما يقابل علّيّين و معناه علو على علو مضاعف ففيه شيء من معنى السفل و الانحباس فيه كما يشير إليه قوله:( ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ ) التين: 5 فالأقرب أن يكون مبالغة من السجن بمعنى الحبس كسكّير و شرّيب من السكر و الشرب فمعناه الّذي يحبس من دخله على التخليد كما قيل.
و الكتاب بمعنى المكتوب من الكتابة بمعنى القضاء المحتوم و المراد بكتاب الفجّار ما قدّره الله لهم من الجزاء و أثبته بقضائه المحتوم.
فمحصّل الآية أنّ الّذي أثبته الله من جزائهم أو عدّه لهم لفي سجّين الّذي هو سجن يحبس من دخله حبساً طويلاً أو خالداً.
و قوله:( وَ ما أَدْراكَ ما سِجِّينٌ ) مسوق للتهويل.
و قوله:( كِتابٌ مَرْقُومٌ ) خبر لمبتدإ محذوف هو ضمير راجع إلى سجّين و الجملة بيان لسجّين و( كتاب ) أيضاً بمعنى المكتوب من الكتابة بمعنى القضاء و الإثبات، و( مرقوم ) من الرقم، قال الراغب: الرقم الخطّ الغليظ، و قيل: هو تعجيم الكتاب، و قوله تعالى:( كِتابٌ مَرْقُومٌ ) حمل على الوجهين. انتهى، و المعنى الثاني أنسب للمقام فيكون إشارة إلى كون ما كتب لهم متبيّناً لا إبهام فيه أي إنّ القضاء حتم لا يتخلّف.
و المحصّل أنّ سجّين مقضيّ عليهم مثبت لهم متبيّن متميّز لا إبهام فيه.
و لا ضير في لزوم كون الكتاب ظرفاً للكتاب على هذا المعنى لأنّ ذلك من ظرفية الكلّ للجزء و هي ممّا لا ضير فيه فيكون سجّين كتاباً جامعاً فيه ما قضي على الفجّار و غيرهم من مستحقّي العذاب.
و قوله:( وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ) نعي و دعاء على الفجّار و فيه تفسيرهم بالمكذّبين، و( يَوْمَئِذٍ ) ظرف لقوله:( إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ) بحسب
المعنى أي ليهلك الفجّار - و هم المكذّبون - يومئذ تحقّق ما كتب الله لهم و قضى عليهم من الجزاء و حلّ بهم ما أعدّ لهم من العذاب.
هذا ما يفيده التدبّر في هذه الآيات الأربع، و هي ذات سياق واحد متّصل متلائم الأجزاء.
و للقوم في تفسير مفردات الآيات الأربع و جملها أقوال متفرّقة كقولهم: إنّ الكتاب في قوله:( إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ ) بمعنى المكتوب و المراد به صحيفة أعمالهم، و قيل: مصدر بمعنى الكتابة و في الكلام مضاف محذوف و التقدير كتابة عمل الفجّار لفي سجّين.
و قولهم: إنّ الفجّار أعمّ من المكذّبين فيشمل الكفّار و الفسقة جميعاً.
و قولهم: إنّ المراد بسجّين الأرض السابعة السفلى يوضع فيها كتاب الفجّار و قيل: واد في جهنّم، و قيل: جبّ فيها، و قيل: سجّين اسم لكتابهم، و قيل: سجّين الأوّل اسم الموضع الّذي يوضع فيه كتابهم و الثاني اسم كتابهم، و قيل: هو اسم كتاب جامع هو ديوان الشرّ دوّن فيه أعمال الفجرة من الثقلين، و قيل: المراد به الخسار و الهوان فهو كقولهم: بلغ فلان الحضيض إذا صار في غاية الخمول، و قيل: هو السجّيل بدّل لامه نوناً كما يقال جبرين في جبريل إلى غير ذلك ممّا قيل.
و قولهم: إنّ قوله:( كِتابٌ مَرْقُومٌ ) ليس بياناً و تفسيراً لسجّين بل تفسير للكتاب المذكور في قوله:( إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ ) .
و قولهم: إنّ قوله:( وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ) متّصل بقوله:( يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ ) و الآيات الثلاث الواقعة بين الآيتين اعتراض.
و أنت إن تأمّلت هذه الأقاويل وجدت كثيراً منها تحكّماً محضاً لا دليل عليه.
على أنّها تقطع ما في الآيات من السياق الواحد المتّصل الّذي يحاذي به ما في الآيات الأربع الآتية في صفة كتاب الأبرار من السياق الواحد المتّصل فلا نطيل الكلام بالتعرّض لواحد واحد منها و المناقشة فيها.
قوله تعالى: ( الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ) تفسير للمكذّبين و ظاهر الآية - و يؤيّده الآيات التالية - أنّ المراد بالتكذيب هو التكذيب القوليّ الصريح فيختصّ الذمّ بالكفّار و لا يشمل الفسقة من أهل الإيمان فلا يشمل مطلق المطفّفين بل الكفّار منهم.
اللّهمّ إلّا أن يراد بالتكذيب ما يعمّ التكذيب العمليّ كما ربّما أيّده قوله السابق:( أَ لا يَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ) فيشمل الفجّار من المؤمنين كالكفّار.
قوله تعالى: ( وَ ما يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ) المعتدي اسم فاعل من الاعتداء بمعنى التجاوز و المراد به المتجاوز عن حدود العبوديّة، و الأثيم كثير الآثام بحيث تراكم بعضها على بعض بانهماكه في الأهواء.
و من المعلوم أنّ المانع الوحيد الّذي يردع عن المعصية هو الإيمان بالبعث و الجزاء، و المنهمك في الأهواء المتعلّق قلبه بالاعتداء و الإثم تأبى نفسه التسليم لما يردع عنها و التزهّد عن المعاصي و ينتهي إلى تكذيب البعث و الجزاء قال تعالى:( ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللهِ وَ كانُوا بِها يَسْتَهْزِؤُنَ ) الروم: 10.
قوله تعالى: ( إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا قالَ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ ) المراد بالآيات آيات القرآن بقرينة قوله( تُتْلى ) و الأساطير ما سطروه و كتبوه و المراد بها أباطيل الاُمم الماضين و المعنى إذا تتلى عليه آيات القرآن ممّا يحذّرهم المعصية و ينذرهم بالبعث و الجزاء قال: هي أباطيل.
قوله تعالى: ( كَلَّا بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ ) ردع عمّا قاله المكذّبون:( أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ ) قال الراغب: الرين صدا يعلو الشيء الجليل(1) قال تعالى:( بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ ) أي صار ذلك كصدء على جلاء قلوبهم فعمي عليهم معرفة الخير من الشرّ، انتهى. فكون ما كانوا يكسبون و هو الذنوب ريناً على
____________________
(1) الجلي ظ.
قلوبهم هو حيلولة الذنوب بينهم و بين أن يدركوا الحقّ على ما هو عليه.
و يظهر من الآية:
أوّلاً: أنّ للأعمال السيّئة نقوشاً و صوراً في النفس تنتقش و تتصوّر بها.
و ثانياً: أنّ هذه النقوش و الصور تمنع النفس أن تدرك الحقّ كما هو و تحول بينها و بينه.
و ثالثاً: أنّ للنفس بحسب طبعها الأوّلي صفاءً و جلاءً تدرك به الحقّ كما هو و تميّز بينه و بين الباطل و تفرّق بين التقوى و الفجور قال تعالى:( وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها ) الشمس: 8.
قوله تعالى: ( كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ) ردع عن كسب الذنوب الحائلة بين القلب و إدراك الحقّ، و المراد بكونهم محجوبين عن ربّهم يوم القيامة حرمانهم من كرامة القرب و المنزلة و لعلّه مراد من قال: إنّ المراد كونهم محجوبين عن رحمة ربّهم.
و أمّا ارتفاع الحجاب بمعنى سقوط الأسباب المتوسّطة بينه تعالى و بين خلقه و المعرفة التامّة به تعالى فهو حاصل لكلّ أحد قال تعالى:( لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ ) المؤمن: 16 و قال:( وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ) النور: 25.
قوله تعالى: ( ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصالُوا الْجَحِيمِ ) أي داخلون فيها ملازمون لها أو مقاسون حرّها على ما فسّره بعضهم و( ثُمَّ ) في الآية و ما بعدها للتراخي بحسب رتبة الكلام.
قوله تعالى: ( ثُمَّ يُقالُ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ) هو توبيخ و تقريع و القائل خزنة النار أو أهل الجنّة.
قوله تعالى: ( كَلَّا إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَ ما أَدْراكَ ما عِلِّيُّونَ كِتابٌ مَرْقُومٌ ) ردع في معنى الردع الّذي في قوله:( كَلَّا إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ ) و
علّيّون - كما تقدّم - علو على علو مضاعف، و ينطبق على الدرجات العالية و منازل القرب من الله تعالى كما أنّ السجّين بخلافه.
و الكلام في معنى الآيات الثلاث نظير الكلام في الآيات الثلاث المتقدّمة الّتي تحاذيها من قوله:( إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَ ما أَدْراكَ ما سِجِّينٌ كِتابٌ مَرْقُومٌ ) .
فالمعنى أنّ الّذي كتب للأبرار و قضي جزاءً لبرّهم لفي علّيّين و ما أدراك ما علّيّون هو أمر مكتوب و مقضيّ قضاءً حتماً لازماً متبيّن لا إبهام فيه.
و للقوم أقاويل في هذه الآيات نظير ما لهم في الآيات السابقة من الأقوال غير أنّ من أقوالهم في علّييّن أنّه السماء السابعة تحت العرش فيه أرواح المؤمنين، و قيل سدرة المنتهى الّتي إليها تنتهي الأعمال، و قيل: لوح من زبرجدة تحت العرش معلّق مكتوب فيه أعمالهم، و قيل: هي مراتب عالية محفوفة بالجلالة، و الكلام فيها كالكلام فيما تقدّم من أقوالهم.
قوله تعالى: ( يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ) الأنسب لما تقدّم من معنى الآيات السابقة أن يكون( يَشْهَدُهُ ) من الشهود بمعنى المعاينة و المقرّبون قوم من أهل الجنّة هم أعلى درجة من عامّة الأبرار على ما سيأتي استفادته من قوله:( عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ) فالمراد معاينتهم له بإراءة الله إيّاه لهم و قد قال الله تعالى في مثله من أمر الجحيم:( كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ) التكاثر: 6 و منه يظهر أنّ المقرّبين هم أهل اليقين.
و قيل: الشهادة هي الحضور و المقرّبون الملائكة، و المراد حضور الملائكة على صحيفة عملهم إذا صعدوا بها إلى الله سبحانه.
و قيل: المقرّبون هم الأبرار و الملائكة جميعاً.
و القولان مبنيّان على أنّ المراد بالكتاب صحيفة الأعمال و قد تقدّم ضعفه.
( بحث روائي)
في تفسير القمّيّ، و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرعليهالسلام قال: نزلت يعني سورة المطفّفين على نبيّ اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم حين قدم المدينة و هم يومئذ أسوأ الناس كيلاً فأحسنوا الكيل.
و في اُصول الكافي، بإسناده عن أبي حمزة الثماليّ قال: سمعت أبا جعفرعليهالسلام يقول: إنّ الله عزّوجلّ خلقنا من أعلى علّيّين و خلق قلوب شيعتنا ممّا خلقنا منه و خلق أبدانهم من دون ذلك فقلوبهم تهوي إلينا لأنّها خلقت ممّا خلقنا ثمّ تلا هذه الآية( كَلَّا إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَ ما أَدْراكَ ما عِلِّيُّونَ كِتابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ) .
و خلق قلوب عدوّنا من سجّين و خلق قلوب شيعتهم ممّا خلقهم منه و أبدانهم من دون ذلك، قلوبهم تهوي إليهم لأنّها خلقت ممّا خلقوا منه ثمّ تلا هذه الآية( كَلَّا إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَ ما أَدْراكَ ما سِجِّينٌ كِتابٌ مَرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ) .
أقول: و روي مثله في اُصول الكافي، بطريق آخر عن الثماليّ عنهعليهالسلام ، و رواه في علل الشرائع، بإسناد فيه رفع عن زيد الشحّام عن أبي عبداللهعليهالسلام : مثله، و الأحاديث - كما ترى - تؤيّد ما قدّمناه في معنى الآيات.
و في تفسير القمّيّ: في قوله تعالى:( كَلَّا إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ) قال: ما كتب الله لهم من العذاب لفي سجّين.
و فيه، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرعليهالسلام قال: السجّين الأرض السابعة و علّيّون السماء السابعة.
أقول: الرواية لو صحّت مبنيّة على انتساب الجنّة و النار إلى جهتي العلو و السفل بنوع من العناية و لذلك نظائر في الروايات كعدّ القبر روضة من رياض
الجنّة أو حفرة من حفر النار و عدّ وادي برهوت مكاناً لجهنّم.
و في الدرّ المنثور، أخرج ابن المبارك عن سعيد بن المسيّب قال: التقى سلمان و عبدالله بن سلام فقال أحدهما لصاحبه: إن متّ قبلي فالقني فأخبرني بما صنع ربّك بك و إن أنا متّ قبلك لقيتك فأخبرتك فقال عبدالله: كيف يكون هذا؟ قال: نعم إنّ أرواح المؤمنين تكون في برزخ من الأرض تذهب حيث شاءت و نفس الكافر في سجّين و الله أعلم.
و في اُصول الكافي، بإسناده عن زرارة عن أبي جعفرعليهالسلام قال: ما من عبد إلّا و في قلبه نكتة بيضاء فإذا أذنب ذنباً خرج في تلك النكتة نكتة سوداء فإن تاب ذهب ذلك السواد، و إن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتّى يغطّي البياض فإذا غطّى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبداً و هو قول الله عزّوجلّ:( كَلَّا بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ ) .
أقول: و روي هذا المعنى في الدرّ المنثور، عن عدّة من أصحاب الجوامع عن أبي هريرة عن النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم .
و فيه، بإسناده عن عبدالله بن محمّد الحجّال عن بعض أصحابنا رفعه قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : تذاكروا و تلاقوا و تحدّثوا فإنّ الحديث جلاء للقلوب إنّ القلوب لترين كما يرين السيف و جلاؤه الحديث.
و عن روضة الواعظين، قال الباقرعليهالسلام : ما شيء أفسد للقلب من الخطيئة إنّ القلب ليواقع الخطيئة فما تزال به حتّى تغلب عليه فيصير أسفله أعلاه و أعلاه أسفله.
قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّ المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب و نزع و استغفر صقل قلبه منه و إن ازداد زادت فذلك الران الّذي ذكره الله تعالى في كتابه( كَلَّا بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ ) .
( سورة المطفّفين الآيات 22 - 36)
إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ( 22 ) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ( 23 ) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ( 24 ) يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ( 25 ) خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ( 26 ) وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ( 27 ) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ( 28 ) إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ( 29 ) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ( 30 ) وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ ( 31 ) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ( 32 ) وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ( 33 ) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ( 34 ) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ( 35 ) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ( 36 )
( بيان)
بيان فيه بعض التفصيل لجلالة قدر الأبرار و عظم منزلتهم عند الله تعالى و غزارة عيشهم في الجنّة، و أنّهم على كونهم يستهزئ بهم الكفّار و يتغامزون بهم و يضحكون منهم سيضحكون منهم و ينظرون إلى ما ينالهم من العذاب.
قوله تعالى: ( إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ ) النعيم النعمة الكثيرة و في تنكيره دلالة على فخامة قدره، و المعنى إنّ الأبرار لفي نعمة كثيرة لا يحيط بها الوصف.
قوله تعالى: ( عَلَى الْأَرائِكِ يَنْظُرُونَ ) الأرائك جمع أريكة و الأريكة السرير
في الجملة و هي البيت المزيّن للعروس و إطلاق قوله:( يَنْظُرُونَ ) من غير تقييد يؤيّد أن يكون المراد نظرهم إلى مناظر الجنّة البهجة و ما فيها من النعيم المقيم، و قيل: المراد به النظر إلى ما يجزي به الكفّار و ليس بذاك.
قوله تعالى: ( تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ) النضرة البهجة و الرونق، و الخطاب للنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم باعتبار أنّ له أن ينظر فيعرف فالحكم عامّ و المعنى كلّ من نظر إلى وجوههم يعرف فيها بهجة النعيم الّذي هم فيه.
قوله تعالى: ( يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ) الرحيق الشراب الصافي الخالص من الغشّ، و يناسبه وصفه بأنّه مختوم فإنّه إنّما يختم على الشيء النفيس الخالص ليسلم من الغشّ و الخلط و إدخال ما يفسده فيه.
قوله تعالى: ( خِتامُهُ مِسْكٌ وَ فِي ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ ) قيل الختام بمعنى ما يختم به أي إنّ الّذي يختم به مسك بدلاً من الطين و نحوه الّذي يختم به في الدنيا، و قيل: أي آخر طعمه الّذي يجده شاربه رائحة المسك.
و قوله:( وَ فِي ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ ) التنافس التغالب على الشيء و يفيد بحسب المقام معنى التسابق قال تعالى:( سابِقُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ ) الحديد: 21، و قال:( فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ ) المائدة: 48، ففيه ترغيب إلى ما وصف من الرحيق المختوم.
و استشكل في الآية بأنّ فيها دخول العاطف على العاطف إذ التقدير فليتنافس في ذلك إلخ.
و اُجيب بأنّ الكلام على تقدير حرف الشرط و الفاء واقعة في جوابه و قدّم الظرف ليكون عوضاً عن الشرط و التقدير و إن اُريد تنافس فليتنافس في ذلك المتنافسون.
و يمكن أن يقال: إنّ قوله:( وَ فِي ذلِكَ ) معطوف على ظرف آخر محذوف متعلّق بقوله:( فَلْيَتَنافَسِ ) يدلّ عليه المقام فإنّ الكلام في وصف نعيم الجنّة فيفيد قوله:( وَ فِي ذلِكَ ) ترغيباً مؤكّداً بتخصيص الحكم بعد التعميم، و المعنى فليتنافس
المتنافسون في نعيم الجنّة عامّة و في الرحيق المختوم الّذي يسقونه خاصّة فهو كقولنا: أكرم المؤمنين و الصالحين منهم خاصّة، و لا تكن عيّاباً و للعلماء خاصّة.
قوله تعالى: ( وَ مِزاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ) المزاج ما يمزج به، و التسنيم على ما تفسّره الآية التالية عين في الجنّة سمّاه الله تسنيماً و في لفظه معنى الرفع و الملء يقال: سنّمه أي رفعه و منه سنام الإبل، و يقال: سنّم الإناء أي ملأه.
قوله تعالى: ( عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ) يقال: شربه و شرب به بمعنى و( عَيْناً ) منصوب على المدح أو الاختصاص و( يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ) وصف لها و المجموع تفسير للتسنيم.
و مفاد الآية أنّ المقرّبين يشربون التسنيم صرفاً كما أنّ مفاد قوله:( وَ مِزاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ) أنّه يمزج بها ما في كأس الأبرار من الرحيق المختوم، و يدلّ ذلك أوّلاً على أنّ التسنيم أفضل من الرحيق المختوم الّذي يزيد لذّة بمزجها، و ثانياً أنّ المقرّبين أعلى درجة من الأبرار الّذين يصفهم الآيات.
قوله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ) يعطي السياق أنّ المراد بالّذين آمنوا هم الأبرار الموصوفون في الآيات و إنّما عبّر عنهم بالّذين آمنوا لأنّ سبب ضحك الكفّار منهم و استهزائهم بهم إنّما هو إيمانهم كما أنّ التعبير عن الكفّار بالّذين أجرموا للدلالة على أنّهم بذلك من المجرمين.
قوله تعالى: ( وَ إِذا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغامَزُونَ ) عطف على قوله:( يَضْحَكُونَ ) أي كانوا إذا مرّوا بالّذين آمنوا يغمز بعضهم بعضاً و يشيرون بأعينهم استهزاءً بهم.
قوله تعالى: ( وَ إِذَا انْقَلَبُوا إِلى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ) الفكه بالفتح فالكسر المرح البطر، و المعنى و كانوا إذا انقلبوا و صاروا إلى أهلهم عن ضحكهم و تغامزهم انقلبوا ملتذّين فرحين بما فعلوا أو هو من الفكاهة بمعنى حديث ذوي الاُنس و المعنى انقلبوا و هم يحدّثون بما فعلوا تفكّها.
قوله تعالى: ( وَ إِذا رَأَوْهُمْ قالُوا إِنَّ هؤُلاءِ لَضالُّونَ ) على سبيل الشهادة عليهم بالضلال أو القضاء عليهم و الثاني أقرب.
قوله تعالى: ( وَ ما أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حافِظِينَ ) أي و ما اُرسل هؤلاء الّذين أجرموا حافظين على المؤمنين يقضون في حقّهم بما شاؤا أو يشهدون عليهم بما هووا، و هذا تهكّم بالمستهزئين.
قوله تعالى: ( فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ) المراد باليوم يوم الجزاء، و التعبير عن الّذين أجرموا بالكفّار رجوع إلى حقيقة صفتهم. قيل: تقديم الجار و المجرور على الفعل أعني( مِنَ الْكُفَّارِ ) على( يَضْحَكُونَ ) لإفادة قصر القلب، و المعنى فاليوم الّذين آمنوا يضحكون من الكفّار لا الكفّار منهم كما كانوا يفعلون في الدنيا.
قوله تعالى: ( عَلَى الْأَرائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ ما كانُوا يَفْعَلُونَ ) الثواب في الأصل مطلق الجزاء و إن غلب استعماله في الخير، و قوله( عَلَى الْأَرائِكِ ) خبر بعد خبر للّذين آمنوا و( يَنْظُرُونَ ) خبر آخر، و قوله:( هَلْ ثُوِّبَ ) إلخ متعلّق بقوله:( يَنْظُرُونَ ) قائم مقام المفعول.
و المعنى: الّذين آمنوا على سرر في الحجال ينظرون إلى جزاء الكفّار بأفعالهم الّتي كانوا يفعلونها في الدنيا من أنواع الإجرام و منها ضحكهم من المؤمنين و تغامزهم إذا مرّوا بهم و انقلابهم إلى أهلهم فكهين و قولهم: إنّ هؤلاء لضالّون.
( بحث روائي)
في تفسير القمّيّ: في قوله تعالى:( وَ فِي ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ ) قال: فيما ذكرناه من الثواب الّذي يطلبه المؤمن.
و في المجمع: في قوله تعالى:( وَ إِذا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغامَزُونَ ) قيل نزلت في عليّ بن أبي طالبعليهالسلام و ذلك أنّه كان في نفر من المسلمين جاؤا إلى النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم فسخر منهم المنافقون و ضحكوا و تغامزوا ثمّ رجعوا إلى أصحابهم فقالوا: رأينا اليوم الأصلع
فضحكنا منه فنزلت الآية قبل أن يصل عليّ و أصحابه إلى النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم : عن مقاتل و الكلبيّ.
أقول: و قد أورده في الكشّاف.
و فيه ذكر الحاكم أبوالقاسم الحسكانيّ في كتاب شواهد التنزيل لقواعد التفصيل بإسناده عن أبي صالح عن ابن عبّاس قال:( إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ) منافقوا قريش و( الَّذِينَ آمَنُوا ) عليّ بن أبي طالب و أصحابه.
و في تفسير القمّيّ:( إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا - إلى قوله -فَكِهِينَ ) قال: يسخرون.
( سورة الانشقاق مكّيّة و هي خمس و عشرون آية)
( سورة الانشقاق الآيات 1 - 25)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ( 1 ) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ( 2 ) وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ( 3 ) وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ( 4 ) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ( 5 ) يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ( 6 ) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ( 7 ) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ( 8 ) وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ( 9 ) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ( 10 ) فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ( 11 ) وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ( 12 ) إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ( 13 ) إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ( 14 ) بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ( 15 ) فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ( 16 ) وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ( 17 ) وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ( 18 ) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ( 19 ) فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ( 20 ) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ( 21 ) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ( 22 ) وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ( 23 ) فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ( 24 ) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ( 25 )
( بيان)
تشير السورة إلى قيام الساعة، و تذكر أنّ للإنسان سيراً إلى ربّه حتّى يلاقيه فيحاسب على ما يقتضيه كتابه و تؤكّد القول في ذلك و الغلبة فيها للإنذار على التبشير. و سياق آياتها سياق مكّي.
قوله تعالى: ( إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ ) شرط جزاؤه محذوف يدلّ عليه قوله:( يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ ) و التقدير: لاقى الإنسان ربّه فحاسبه و جازاه على ما عمل.
و انشقاق السماء و هو تصدّعه و انفراجه من أشراط الساعة كمدّ الأرض و سائر ما ذكر في مواضع من كلامه تعالى من تكوير الشمس و اجتماع الشمس و القمر و انتثار الكواكب و نحوها.
قوله تعالى: ( وَ أَذِنَتْ لِرَبِّها وَ حُقَّتْ ) الإذن الاستماع و منه الاُذن لجارحة السمع و هو مجاز عن الانقياد و الطاعة، و( حُقَّتْ ) أي جعلت حقيقة و جديرة بأن تسمع، و المعنى و أطاعت و انقادت لربّها و كانت حقيقة و جديرة بأن تستمع و تطيع.
قوله تعالى: ( وَ إِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ) الظاهر أنّ المراد به اتّساع الأرض، و قد قال تعالى:( يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ ) إبراهيم: 48.
قوله تعالى: ( وَ أَلْقَتْ ما فِيها وَ تَخَلَّتْ ) أي ألقت الأرض ما في جوفها من الموتى و بالغت في الخلوّ ممّا فيها منهم.
و قيل: المراد إلقائها الموتى و الكنوز كما قال تعالى:( وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها ) الزلزال: 2.
و قيل: المعنى ألقت ما في بطنها و تخلّت ممّا على ظهرها من الجبال و البحار، و لعلّ أوّل الوجوه أقربها.
قوله تعالى: ( وَ أَذِنَتْ لِرَبِّها وَ حُقَّتْ ) ضمائر التأنيث للأرض كما أنّها في
نظيرتها المتقدّمة للسماء، و قد تقدّم معنى الآية.
قوله تعالى: ( يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ ) قال الراغب: الكدح السعي و العناء. انتهى. ففيه معنى السير، و قيل: الكدح جهد النفس في العمل حتّى يؤثّر فيها انتهى. و على هذا فهو مضمّن معنى السير بدليل تعدّيه بإلى ففي الكدح معنى السير على أيّ حال.
و قوله:( فَمُلاقِيهِ ) عطف على( كادِحٌ ) و قد بيّن به أنّ غاية هذا السير و السعي و العناء هو الله سبحانه بما أنّ له الربوبيّة أي إنّ الإنسان بما أنّه عبد مربوب و مملوك مدبّر ساع إلى الله سبحانه بما أنّه ربّه و مالكه المدبّر لأمره فإنّ العبد لا يملك لنفسه إرادة و لا عملاً فعليه أن يريد و لا يعمل إلّا ما أراده ربّه و مولاه و أمره به فهو مسؤل عن إرادته و عمله.
و من هنا يظهر أوّلاً أنّ قوله:( إِنَّكَ كادِحٌ إِلى رَبِّكَ ) يتضمّن حجّة على المعاد لما عرفت أنّ الربوبيّة لا تتمّ إلّا مع عبوديّة و لا تتمّ العبوديّة إلّا مع مسؤليّة و لا تتمّ مسؤليّة إلّا برجوع و حساب على الأعمال و لا يتمّ حساب إلّا بجزاء.
و ثانياً: أنّ المراد بملاقاته انتهاؤه إلى حيث لا حكم إلّا حكمه من غير أن يحجبه عن ربّه حاجب.
و ثالثاً: أنّ المخاطب في الآية هو الإنسان بما أنّه إنسان فالمراد به الجنس و ذلك أنّ الربوبيّة عامّة لكلّ إنسان.
قوله تعالى: ( فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ ) تفصيل مترتّب على ما يلوّح إليه قوله:( إِنَّكَ كادِحٌ إِلى رَبِّكَ ) أنّ هناك رجوعاً و سؤالاً عن الأعمال و حساباً، و المراد بالكتاب صحيفة الأعمال بقرينة ذكر الحساب، و قد تقدّم الكلام في معنى إعطاء الكتاب باليمين في سورتي الإسراء و الحاقّة.
قوله تعالى: ( فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً ) الحساب اليسير ما سوهل فيه و خلا عن المناقشة.
قوله تعالى: ( وَ يَنْقَلِبُ إِلى أَهْلِهِ مَسْرُوراً ) المراد بالأهل من أعدّه الله له في
الجنّة من الحور و الغلمان و غيرهم و هذا هو الّذي يفيده السياق، و قيل: المراد به عشيرته المؤمنون ممّن يدخل الجنّة، و قيل المراد فريق المؤمنين و إن لم يكونوا من عشيرته فالمؤمنون إخوة. و الوجهان لا يخلوان من بعد.
قوله تعالى: ( وَ أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ ) الظرف منصوب بنزع الخافض و التقدير من وراء ظهره، و لعلّهم إنّما يؤتون كتبهم من وراء ظهورهم لردّ وجوههم على أدبارهم كما قال تعالى:( مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها ) النساء: 47.
و لا منافاة بين إيتاء كتابهم من وراء ظهورهم و بين إيتائهم بشمالهم كما وقع في قوله تعالى:( وَ أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِشِمالِهِ فَيَقُولُ يا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتابِيَهْ ) الحاقّة: 25 و سيأتي في البحث الروائيّ التالي ما ورد في الروايات من معنى إيتاء الكتاب من وراء ظهورهم.
قوله تعالى: ( فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً ) الثبور كالويل الهلاك و دعاؤهم الثبور قولهم: وا ثبوراه.
قوله تعالى: ( وَ يَصْلى سَعِيراً ) أي يدخل ناراً مؤجّجة لا يوصف عذابها، أو يقاسي حرّها.
قوله تعالى: ( إِنَّهُ كانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً ) يسرّه ما يناله من متاع الدنيا و تنجذب نفسه إلى زينتها و ينسيه ذلك أمر الآخرة و قد ذمّ تعالى فرح الإنسان بما يناله من خير الدنيا و سمّاه فرحاً بغير حقّ قال تعالى بعد ذكر النار و عذابها:( ذلِكُمْ بِما كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ بِما كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ) المؤمن: 75.
قوله تعالى: ( إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ) أي لن يرجع و المراد الرجوع إلى ربّه للحساب و الجزاء، و لا سبب يوجبه عليهم إلّا التوغّل في الذنوب و الآثام الصارفة عن الآخرة الداعية إلى استبعاد البعث.
قوله تعالى: ( بَلى إِنَّ رَبَّهُ كانَ بِهِ بَصِيراً ) ردّ لظنّه أي ليس الأمر كما ظنّه بل يحور و يرجع، و قوله:( إِنَّ رَبَّهُ كانَ بِهِ بَصِيراً ) تعليل للردّ المذكور فإنّ الله
سبحانه كان ربّه المالك له المدبّر لأمره و كان يحيط به علماً و يرى ما كان من أعماله و قد كلّفه بما كلّف و لأعماله جزاء خيراً أو شرّاً فلا بدّ أن يرجع إليه و يجزي بما يستحقّه بعمله.
و بذلك يظهر أنّ قوله:( إِنَّ رَبَّهُ كانَ بِهِ بَصِيراً ) من إعطاء الحجّة على وجوب المعاد نظير ما تقدّم في قوله:( إِنَّكَ كادِحٌ إِلى رَبِّكَ ) الآية.
و يظهر أيضاً من مجموع هذه الآيات التسع أنّ إيتاء الكتب و نشر الصحف قبل الحساب كما يدلّ عليه أيضاً قوله تعالى:( وَ كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً اقْرَأْ كِتابَكَ كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً ) إسراء: 14.
ثمّ الآيات كما ترى تخصّ إيتاء الكتاب من وراء الظهر بالكفّار فيقع الكلام في عصاة المؤمنين من أصحاب الكبائر ممّن يدخل النار فيمكث فيها برهة ثمّ يخرج منها بالشفاعة على ما في الأخبار من طرق الفريقين فهؤلاء لا يؤتون كتابهم من وراء ظهورهم لاختصاص ذلك بالكفّار و لا بيمينهم لظهور الآيات في أنّ أصحاب اليمين يحاسبون حساباً يسيراً و يدخلون الجنّة، و لا سبيل إلى القول بأنّهم لا يؤتون كتاباً لمكان قوله تعالى:( وَ كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ) الآية المفيد للعموم.
و قد تخلّص بعضهم عن الإشكال بأنّهم يؤتون كتابهم باليمين بعد الخروج من النار.
و فيه أنّ ظاهر الآيات إن لم يكن صريحها أنّ دخول النار أو الجنّة فرع مترتّب على القضاء المترتب على الحساب المترتّب على إيتاء الكتب و نشر الصحف فلا معنى لإيتاء الكتاب بعد الخروج من النار.
و احتمل بعضهم أن يؤتوا كتابهم بشمالهم و يكون الإيتاء من وراء الظهر مخصوصاً بالكفّار كما تفيده الآيات.
و فيه أنّ الآيات الّتي تذكر إيتاء الكتاب بالشمال - و هي الّتي في سورة الواقعة و الحاقّة و في معناها ما في سورة الإسراء أيضاً - تخصّ إيتاء الكتاب بالشمال بالكفّار
و يظهر من مجموع الآيات أنّ الّذين يؤتون كتابهم بشمالهم هم الّذين يؤتونه من وراء ظهورهم.
و قال بعضهم من الممكن أن يؤتوا كتابهم من وراء ظهورهم و يكون قوله:( فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً ) من قبيل وصف الكلّ بصفة بعض أجزائه.
و فيه أنّ المقام لا يساعد على هذا التجوّز فإنّ المقام مقام تمييز السعداء من الأشقياء و تشخيص كلّ بجزائه الخاصّ به فلا مجوّز لإدغام جمع من أهل العذاب في أهل الجنّة.
على أنّ قوله:( فَسَوْفَ يُحاسَبُ ) إلخ وعد جميل إلهيّ و لا معنى لشموله لغير مستحقّيه و لو بظاهر من القول.
نعم يمكن أن يقال: إنّ اليسر و العسر معنيان إضافيّان و حساب العصاة من أهل الإيمان يسير بالإضافة إلى حساب الكفّار المخلّدين في النار و لو كان عسيراً بالإضافة إلى حساب المتّقين.
و يمكن أيضاً أن يقال إنّ قسمة أهل الجمع إلى أصحاب اليمين و أصحاب الشمال غير حاصرة كما يدلّ عليه قوله تعالى:( وَ كُنْتُمْ أَزْواجاً ثَلاثَةً فَأَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ ما أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ وَ أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ ما أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ) الواقعة: 11 فمدلول الآيات خروج المقرّبين من الفريقين، و مثلهم المستضعفون كما ربّما يستفاد من قوله تعالى:( وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَ إِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ) التوبة: 106.
فمن الجائز أن لا يكون تقسيم أهل الجمع إلى أصحاب اليمين و أصحاب الشمال تقسيماً حاصراً لجميعهم بل تخصيصاً لأهل الجنّة من المتّقين و أهل الخلود في النار بالذكر بتوصيفهم بإيتاء الكتاب باليمين و بالشمال لمكان الدعوة إلى الإيمان و التقوى و نظير ذلك ما في سورة المرسلات من ذكر يوم الفصل ثمّ بيان حال المتّقين و المكذّبين فحسب و ليس ينحصر الناس في القبيلين، و نظيره ما في سورة النبإ و النازعات و عبس و الانفطار، و المطفّفين و غيرها فالغرض فيها ذكر اُنموذج من أهل الإيمان و الطاعة و أهل الكفر
و التكذيب و السكوت عمّن سواهم ليتذكّر أنّ السعادة في جانب التقوى و الشقاء في جانب التمرّد و الطغوى.
قوله تعالى: ( فَلا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ) الشفق الحمرة ثمّ الصفرة ثمّ البياض الّتي تحدث بالمغرب أوّل الليل.
قوله تعالى: ( وَ اللَّيْلِ وَ ما وَسَقَ ) أي ضمّ و جمع ما تفرّق و انتشر في النهار من الإنسان و الحيوان فإنّها تتفرّق و تنتشر بالطبع في النهار و ترجع إلى مأواها في الليل فتسكن.
و فسّر بعضهم( وسق ) بمعنى طرد أي طرد الكواكب من الخفاء إلى الظهور.
قوله تعالى: ( وَ الْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ) أي اجتمع و انضمّ بعض نوره إلى بعض فاكتمل نوره و تبدّر.
قوله تعالى: ( لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ ) جواب القسم و الخطاب للناس و الطبق هو الشيء أو الحال الّذي يطابق آخر سواء كان أحدهما فوق الآخر أم لا و المراد به كيف كان المرحلة بعد المرحلة يقطعها الإنسان في كدحه إلى ربّه من الحياة الدنيا ثمّ الموت ثمّ الحياة البرزخيّة ثمّ الانتقال إلى الآخرة ثمّ الحياة الآخرة ثمّ الحساب و الجزاء.
و في هذا الإقسام - كما ترى - تأكيد لما في قوله:( يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ ) الآية و ما بعده من نبإ البعث و توطئة و تمهيد لما في قوله:( فَما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ) من التعجيب و التوبيخ و ما في قوله:( فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ ) إلخ من الإنذار و التبشير.
و في الآية إشارة إلى أنّ المراحل الّتي يقطعها الإنسان في مسيره إلى ربّه مترتّبة متطابقة.
قوله تعالى: ( فَما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ وَ إِذا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ ) الاستفهام للتعجيب و التوبيخ و لذا ناسب الالتفات الّذي فيه من الخطاب إلى الغيبة كأنّه لمّا رأى أنّهم لا يتذكّرون بتذكيره و لا يتّعظون بعظته أعرض عنهم إلى النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم فخاطبه بقوله:( فَما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ) إلخ.
قوله تعالى: ( بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَ اللهُ أَعْلَمُ بِما يُوعُونَ ) ( يُكَذِّبُونَ ) يفيد الاستمرار، و التعبير عنهم بالّذين كفروا للدلالة على علّة التكذيب، و الإيعاء كما قيل جعل الشيء في وعاء.
و المعنى: أنّهم لم يتركوا الإيمان لقصور في البيان أو لانقطاع من البرهان لكنّهم اتّبعوا أسلافهم و رؤساءهم فرسخوا في الكفر و استمرّوا على التكذيب و الله يعلم بما جمعوا في صدورهم و أضمروا في قلوبهم من الكفر و الشرك.
و قيل: المراد بقوله:( وَ اللهُ أَعْلَمُ بِما يُوعُونَ ) أنّ لهم وراء التكذيب مضمرات في قلوبهم لا يحيط بها العبارة و لا يعلمها إلّا الله، و هو بعيد من السياق.
قوله تعالى: ( فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ ) التعبير عن الإخبار بالعذاب بالتبشير مبنيّ على التهكّم، و الجملة متفرّعة على التكذيب.
قوله تعالى: ( إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ) استثناء منقطع من ضمير( فَبَشِّرْهُمْ ) و المراد بكون أجرهم غير ممنون خلوّه من قول يثقل على المأجور.
( بحث روائي)
في تفسير القمّيّ: في قوله تعالى:( إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ ) قال: يوم القيامة.
و في الدرّ المنثور، أخرج ابن أبي حاتم عن عليّ قال تنشقّ السماء من المجرّة.
و في تفسير القمّيّ: في قوله:( وَ إِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَ أَلْقَتْ ما فِيها وَ تَخَلَّتْ ) قال: تمدّ الأرض فتنشقّ فيخرج الناس منها.
و في الدرّ المنثور، أخرج الحاكم بسند جيّد عن جابر عن النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: تمدّ الأرض يوم القيامة مدّ الأديم ثمّ لا يكون لابن آدم منها إلّا موضع قدميه.
و في الاحتجاج، عن عليّعليهالسلام في حديث قال و الناس يومئذ على صفات و منازل فمنهم من يحاسب حساباً يسيراً و ينقلب إلى أهله مسروراً، و منهم الّذين يدخلون الجنّة بغير حساب لأنّهم لم يلبسوا من أمر الدنيا بشيء و إنّما الحساب هناك على من
يلبس بها ههنا، و منهم من يحاسب على النقير و القطمير و يصير إلى عذاب السعير.
و في المعاني، بإسناده عن ابن سنان عن أبي جعفرعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : كلّ محاسب معذّب فقال له قائل: يا رسول الله فأين قول الله عزّوجلّ:( فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً ) قال: ذلك العرض يعني التصفّح.
أقول: و روي في الدرّ المنثور، عن البخاريّ و مسلم و الترمذيّ و غيرهم عن عائشة: مثله.
و في تفسير القمّيّ، و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرعليهالسلام في قوله:( فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ ) فهو أبوسلمة عبدالله بن عبدالأسود بن هلال المخزوميّ و هو من بني مخزوم،( وَ أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ ) فهو أخوه الأسود بن عبدالأسود المخزوميّ فقتله حمزة بن عبدالمطّلب يوم بدر.
و في المجمع: في قوله تعالى:( لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ ) و قيل: معناه شدّة بعد شدّة حياة ثمّ موت ثمّ بعث ثمّ جزاء: و روي ذلك مرفوعاً.
و عن جوامع الجامع، في الآية عن أبي عبيدة: لتركبنّ سنن من كان قبلكم من الأوّلين و أحوالهم: و روي ذلك عن الصادقعليهالسلام .
( سورة البروج مكّيّة و هي اثنتان و عشرون آية)
( سورة البروج الآيات 1 - 22)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ( 1 ) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ( 2 ) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ( 3 ) قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ( 4 ) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ( 5 ) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ( 6 ) وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ( 7 ) وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ( 8 ) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ( 9 ) إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ( 10 ) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ( 11 ) إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ( 12 ) إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ( 13 ) وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ( 14 ) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ( 15 ) فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ( 16 ) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ( 17 ) فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ( 18 ) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ( 19 ) وَاللهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ ( 20 ) بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ( 21 ) فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ( 22 )
( بيان)
سورة إنذار و تبشير فيها وعيد شديد للّذين يفتنون المؤمنين و المؤمنات لإيمانهم بالله كما كان المشركون من أهل مكّة يفعلون ذلك بالّذين آمنوا بالنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم فيعذّبونهم ليرجعوا إلى شركهم السابق فمنهم من كان يصبر و لا يرجع بلغ الأمر ما بلغ، و منهم من رجع و ارتدّ و هم ضعفاء الإيمان كما يشير إلى ذلك قوله تعالى:( وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ فَإِذا أُوذِيَ فِي اللهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذابِ اللهِ ) العنكبوت: 10، و قوله:( وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلى حَرْفٍ فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ ) الحجّ: 11.
و قد قدّم سبحانه على ذلك الإشارة إلى قصّة أصحاب الاُخدود، و فيه تحريض المؤمنين على الصبر في جنب الله تعالى، و أتبعها بالإشارة إلى حديث الجنود فرعون و ثمود و فيه تطييب لنفس النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم بوعد النصر و تهديد للمشركين.
و السورة مكّيّة بشهادة سياق آياتها.
قوله تعالى: ( وَ السَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ ) البروج جمع برج و هو الأمر الظاهر و يغلب استعماله في القصر العالي لظهوره على الناظرين و يسمّى البناء المعمول على سور البلد للدفاع برجاً و هو المراد في الآية لقوله تعالى:( وَ لَقَدْ جَعَلْنا فِي السَّماءِ بُرُوجاً وَ زَيَّنَّاها لِلنَّاظِرِينَ وَ حَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ ) الحجر: 17، فالمراد بالبروج مواضع الكواكب من السماء.
و بذلك يظهر أنّ تفسير البروج بالبروج الاثني عشر المصطلح عليها في علم النجوم غير سديد.
و في الآية إقسام بالسماء المحفوظة بالبروج، و لا يخفى مناسبته لما سيشار إليه من القصّة ثمّ الوعيد و الوعد و سنشير إليه.
قوله تعالى: ( وَ الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ) عطف على السماء و إقسام باليوم الموعود و هو يوم القيامة الّذي وعد الله القضاء فيه بين عباده.
قوله تعالى: ( وَ شاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ ) معطوفان على السماء و الجميع قسم بعد قسم على ما اُريد بيانه في السورة و هو - كما تقدّمت الإشارة إليه - الوعيد الشديد لمن يفتن المؤمنين و المؤمنات لإيمانهم و الوعد الجميل لمن آمن و عمل صالحاً.
فكأنّه قيل: اُقسم بالسماء ذات البروج الّتي يدفع الله بها عنها الشياطين إنّ الله يدفع عن إيمان المؤمنين كيد الشياطين و أوليائهم من الكافرين، و اُقسم باليوم الموعود الّذي يجزي فيه الناس بأعمالهم، و اُقسم بشاهد يشهد و يعاين أعمال اُولئك الكفّار و ما يفعلونه بالمؤمنين لإيمانهم بالله و اُقسم بمشهود سيشهده الكلّ و يعاينونه إنّ الّذين فتنوا المؤمنين و المؤمنات، إلى آخر الآيتين.تين.
و من هنا يظهر أنّ الشهادة في( شاهِدٍ ) و( مَشْهُودٍ ) بمعنى واحد و هو المعاينة بالحضور، على أنّها لو كانت بمعنى تأدية الشهادة لكان حقّ التعبير( و مشهود عليه) لأنّها بهذا المعنى إنّما تتعدّى بعلى.
و على هذا يقبل( شاهِدٍ ) الانطباق على النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم لشهادته أعمال اُمّته ثمّ يشهد عليها يوم القيامة، و يقبل( مَشْهُودٍ ) الانطباق على تعذيب الكفّار لهؤلاء المؤمنين و ما فعلوا بهم من الفتنة و إن شئت فقل: على جزائه و إن شئت فقل: على ما يقع يوم القيامة من العقاب و الثواب لهؤلاء الظالمين و المظلومين، و تنكير( مَشْهُودٍ ) و( وَ شاهِدٍ ) على أيّ حال للتفخيم.
و لهم في تفسير شاهد و مشهود أقاويل كثيرة أنهاها بعضهم إلى ثلاثين كقول بعضهم إنّ الشاهد يوم الجمعة و المشهود يوم عرفة، و القول بأنّ الشاهد يوم النحر و المشهود يوم عرفة، و القول بأنّ الشاهد يوم عرفة و المشهود يوم القيامة، و القول بأنّ الشاهد الملك يشهد على بني آدم و المشهود يوم القيامة، و القول بأنّ الشاهد الّذين يشهدون على الناس و المشهود الّذين يشهد عليهم.
و القول بأنّ الشاهد هذه الاُمّة و المشهود سائر الاُمم، و القول بأنّ الشاهد أعضاء بني آدم و المشهود أنفسهم و القول بأنّ الشاهد الحجر الأسود و المشهود الحاجّ و القول بأنّ الشاهد الأيّام و اللّيالي و المشهود بنو آدم، و القول بأنّ الشاهد الأنبياء و المشهود
محمّدصلىاللهعليهوآلهوسلم ، و القول بأنّ الشاهد هو الله و المشهود لا إله إلّا الله.
و القول بأنّ الشاهد الخلق و المشهود الحقّ، و القول بأنّ الشاهد هو الله و المشهود يوم القيامة، و القول بأنّ الشاهد آدم و ذرّيّته و المشهود يوم القيامة، و القول بأنّ الشاهد يوم التروية و المشهود يوم عرفة، و القول بأنّها يوم الإثنين و يوم الجمعة، و القول بأنّ الشاهد: المقرّبون و المشهود علّيّون، و القول بأنّ الشاهد هو الطفل الّذي قال لاُمّه في قصّة الاُخدود: اصبري فإنّك على الحقّ و المشهود الواقعة، و القول بأنّ الشاهد الملائكة المتعاقبون لكتابة الأعمال و المشهود قرآن الفجر إلى غير ذلك من أقوالهم.
و أكثر هذه الأقوال - كما ترى - مبنيّ على أخذ الشهادة بمعنى أداء ما حمّل من الشهادة و بعضها على تفريق بين الشاهد و المشهود في معنى الشهادة و قد عرفت ضعفه، و أنّ الأنسب للسياق أخذها بمعنى المعاينة و إن استلزم الشهادة بمعنى الأداء يوم القيامة، و أنّ الشاهد يقبل الانطباق على النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم .
كيف لا؟ و قد سمّاه الله تعالى شاهداً إذ قال:( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً ) الأحزاب: 45، و سمّاه شهيداً إذ قال:( لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ ) الحجّ: 78، و قد عرفت معنى شهادة الأعمال من شهدائها فيما مرّ.
ثمّ إنّ جواب القسم محذوف يدلّ عليه قوله:( إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ ) إلى تمام آيتين، و يشعر به أيضاً قوله:( قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ ) إلخ و هو وعيد الفاتنين و وعد المؤمنين الصالحين و أنّ الله يوفقهم على الصبر و يؤيّدهم على حفظ إيمانهم من كيد الكائدين أن أخلصوا كما فعل بالمؤمنين في قصّة الاُخدود.
قوله تعالى: ( قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ ) إشارة إلى قصّة الاُخدود لتكون توطئة و تمهيداً لما سيجيء من قوله:( إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا ) إلخ و ليس جواباً للقسم البتّة.
و الاُخدود الشقّ العظيم في الأرض، و أصحاب الاُخدود هم الجبابرة الّذين خدّوا اُخدوداً و أضرموا فيها النار و أمروا المؤمنين بدخولها فأحرقوهم عن آخرهم
نقماً منهم لإيمانهم.
فقوله:( قُتِلَ ) إلخ دعاء عليهم و المراد بالقتل اللعن و الطرد.
و قيل: المراد بأصحاب الاُخدود المؤمنون و المؤمنات الّذين اُحرقوا فيه، و قوله:( قُتِلَ ) إخبار عن قتلهم بالإحراق و ليس من الدعاء في شيء. و يضعّفه ظهور رجوع الضمائر في قوله:( إِذْ هُمْ عَلَيْها ) و( هُمْ عَلى ما يَفْعَلُونَ ) و( ما نَقَمُوا ) إلى أصحاب الاُخدود، و المراد بها و خاصّة بالثاني و الثالث الجبابرة الناقمون دون المؤمنين المعذّبين.
قوله تعالى: ( النَّارِ ذاتِ الْوَقُودِ ) بدل من الاُخدود، و الوقود ما يشعل به النار من حطب و غيره، و في توصيف النار بذات الوقود إشارة إلى عظمة أمر هذه النار و شدّة اشتعالها و أجيجها.
قوله تعالى: ( إِذْ هُمْ عَلَيْها قُعُودٌ ) أي في حال اُولئك الجبابرة قاعدون في أطراف النار المشرفة عليها.
قوله تعالى: ( وَ هُمْ عَلى ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ) أي حضور ينظرون و يشاهدون إحراقهم و احتراقهم.
قوله تعالى: ( وَ ما نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ ) النقم بفتحتين الكراهة الشديدة أي ما كرهوا من اُولئك المؤمنين إلّا إيمانهم بالله فأحرقوهم لأجل إيمانهم.
قوله تعالى: ( الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ) أوصاف جارية على اسم الجلالة تشير إلى الحجّة على أنّ اُولئك المؤمنين كانوا على الحقّ في إيمانهم مظلومين فيما فعل بهم لا يخفى حالهم على الله و سيجزيهم خير الجزاء، و على أنّ اُولئك الجبابرة كانوا على الباطل مجترين على الله ظالمين فيما فعلوا و سيذوقون وبال أمرهم.
و ذلك أنّه تعالى هو الله العزيز الحميد أي الغالب غير المغلوب على الإطلاق و الجميل في فعله على الإطلاق فله وحده كلّ الجلال و الجمال فمن الواجب أن يخضع
له و أن لا يتعرّض لجانبه، و إذ كان له ملك السماوات و الأرض فهو المليك على الإطلاق له الأمر و له الحكم فهو ربّ العالمين فمن الواجب أن يتّخذ إلهاً معبوداً و لا يشرك به أحد فالمؤمنون به على الحقّ و الكافرون في ضلال.
ثمّ إنّ الله - و هو الموجد لكلّ شيء - على كلّ شيء شهيد لا يخفى عليه شيء من خلقه و لا عمل من أعمال خلقه و لا يحتجب عنه إحسان محسن و لا إساءة مسيء فسيجزي كلّاً بما عمل.
و بالجملة إذ كان تعالى هو الله المتّصف بهذه الصفات الكريمة كان على هؤلاء المؤمنين أن يؤمنوا به و لم يكن لاُولئك الجبابرة أن يتعرّضوا لحالهم و لا أن يمسّوهم بسوء.
و قال بعض المفسّرين في توجيه إجراء الصفات في الآية: إنّ القوم إن كانوا مشركين فالّذي كانوا ينقمونه من المؤمنين و ينكرونه عليهم لم يكن هو الإيمان بالله تعالى بل نفي ما سواه من معبوداتهم الباطلة، و إن كانوا معطّلة فالمنكر عندهم ليس إلّا إثبات معبود غير معهود لهم لكن لمّا كان مآل الأمرين إنكار المعبود الحقّ الموصوف بصفات الجلال و الإكرام عبّر بما عبّر بإجراء الصفات عليه تعالى.
و فيه غفلة عن أنّ المشركين و هم الوثنيّة ما كانوا ينسبون إلى الله تعالى إلّا الصنع و الإيجاد. و أمّا الربوبيّة الّتي تستتبع التدبير و الاُلوهيّة الّتي تستوجب العبادة فكانوا يقصرونها في أربابهم و آلهتهم فيعبدونها دون الله سبحانه، فليس له تعالى عندهم إلّا أنّه ربّ الأرباب و إله الآلهة لا غير.
قوله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذابُ الْحَرِيقِ ) الفتنة المحنة و التعذيب،( و الَّذِينَ فَتَنُوا ) إلخ عامّ يشمل أصحاب الاُخدود و مشركي قريش الّذين كانوا يفتنون من آمن بالنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم من المؤمنين و المؤمنات بأنواع من العذاب ليرجعوا عن دينهم.
قال في المجمع: يسأل فيقال: كيف فصّل بين عذاب جهنّم و عذاب الحريق و هما واحد؟ اُجيب عن ذلك بأنّ المراد لهم أنواع العذاب في جهنّم سوى الإحراق
مثل الزّقّوم و الغسلين و المقامع و لهم مع ذلك الإحراق بالنار انتهى.
قوله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ذلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ) وعد جميل للمؤمنين يطيّب به نفوسهم كما أنّ ما قبله وعيد شديد للكفّار الفاتنين المعذّبين.
قوله تعالى: ( إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ) الآية إلى تمام سبع آيات تحقيق و تأكيد لما تقدّم من الوعيد و الوعد، و البطش - كما ذكره الراغب - تناول الشيء بصولة.
و في إضافة البطش إلى الربّ و إضافة الربّ إلى الكاف تطييب لنفس النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم بالتأييد و النصر، و إشارة إلى أنّ لجبابرة اُمّته نصيباً من الوعيد المتقدّم.
قوله تعالى: ( إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَ يُعِيدُ ) المقابلة بين المبدئ و المعيد يعطي أنّ المراد بالإبداء البدء، و الافتتاح بالشيء، قالوا: و لم يسمع من العرب الإبداء لكن القراءة ذلك و في بعض القراءات الشاذّة يبدأ بفتح الياء و الدال.
و على أيّ حال فالآية تعليل لشدّة بطشه تعالى و ذلك أنّه تعالى مبدئ يوجد ما يريده من شيء إيجاداً ابتدائياً من غير أن يستمدّ على ذلك من شيء غير نفسه، و هو تعالى يعيد كلّ ما كان إلى ما كان و كلّ حال فاتته إلى ما كانت عليه قبل الفوت فهو تعالى لا يمتنع عليه ما أراد و لا يفوته فائت زائل و إذ كان كذلك فهو القادر على أن يحمل على العبد المتعدّي حدّه، من العذاب ما هو فوق حدّه و وراء طاقته و يحفظه على ما هو عليه ليذوق العذاب قال تعالى:( وَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَ لا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذابِها ) فاطر: 36.
و هو القادر على أن يعيد ما أفسده العذاب إلى حالته الاُولى ليذوق المجرم بذلك العذاب من غير انقطاع قال تعالى:( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ناراً كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَذُوقُوا الْعَذابَ ) النساء: 56.
و بهذا البيان يتّضح:
أوّلاً: أنّ سياق قوله:( إِنَّهُ هُوَ ) إلخ يفيد القصر أي إنّ إبداع الوجود
و إعادته لله سبحانه وحده إذ الصنع و الإيجاد ينتهي إليه تعالى وحده.
و ثانياً: أنّ حدود الأشياء إليه تعالى و لو شاء أن لا يحدّ لم يحدّ أو بدّل حدّاً من آخر فهو الّذي حدّ العذاب و الفتنة في الدنيا بالموت و الزوال و لو لم يشأ لم يحدّ كما في عذاب الآخرة.
و ثالثاً: أنّ المراد من شدّة البطش - و هو الأخذ بعنف - أن لا دافع لأخذه و لا رادّ لحكمه كيفما حكم إلّا أن يحول بين حكمه و متعلّقه حكم آخر منه يقيّد الأوّل.
قوله تعالى: ( وَ هُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ) أي كثير المغفرة و المودّة ناظر إلى وعد المؤمنين كما أنّ قوله:( إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ ) إلخ ناظر إلى وعيد الكافرين.
قوله تعالى: ( ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ ) العرش عرش الملك، و ذوالعرش كناية عن الملك أي هو ملك له أن يتصرّف في مملكته كيفما تصرّف و يحكم بما شاء و المجيد صفة من المجد و هو العظمة المعنوية و هي كمال الذات و الصفات، و قوله:( فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ ) أي لا يصرفه عمّا أراده صارف لا من داخل لضجر و كسل و ملل و تغيّر إرادة و غيرها و لا من خارج لمانع يحول بينه و بين ما أراد.
فله تعالى أن يوعد الّذين فتنوا المؤمنين و المؤمنات بالنار و يعد الّذين آمنوا و عملوا الصالحات بالجنّة لأنّه ذو العرش المجيد و لن يخلف وعده لأنّه فعّال لما يريد.
قوله تعالى: ( هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَ ثَمُودَ ) تقرير لما تقدّم من شدّة بطشه تعالى و كونه ملكاً مجيداً فعّالاً لما يريد، و فيه تسلية للنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم و تطييب لنفسه الشريفة بالإشارة إلى حديثهم، و معنى الآيتين ظاهر.
قوله تعالى: ( بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ) لا يبعد أن يستفاد من السياق كون المراد بالّذين كفروا هم قوم النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم .
و في الآية إضراب عمّا تقدّم من الموعظة و الحجّة من حيث الأثر، و المعنى لا ينبغي أن يرجى منهم الإيمان بهذه الآيات البيّنات فإنّ الّذين كفروا مصرّون على
تكذيبهم لا ينتفعون بموعظة أو حجّة.
و من هنا ظهر أنّ المراد بكون الّذين كفروا في تكذيب أي بظرفيّة التكذيب لهم إصرارهم عليه.
قوله تعالى: ( وَ اللهُ مِنْ وَرائِهِمْ مُحِيطٌ ) وراء الشيء الجهات الخارجة منه المحيطة به. إشارة إلى أنّهم غير معجزين لله سبحانه فهو محيط بهم قادر عليهم من كلّ جهة، و فيه أيضاً تطييب لنفس النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم .
و عن بعضهم أنّ في قوله:( مِنْ وَرائِهِمْ ) تلويحاً إلى أنّهم اتّخذوا الله وراءهم ظهريّا، و هو مبنيّ على أخذ وراء بمعنى خلف.
قوله تعالى: ( بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ) إضراب عن إصرارهم على تكذيب القرآن، و المعنى ليس الأمر كما يدّعون بل القرآن كتاب مقروّ عظيم في معناه غزير في معارفه في لوح محفوظ عن الكذب و الباطل مصون من مسّ الشياطين.
( بحث روائي)
في الدرّ المنثور، أخرج ابن مردويه عن جابر بن عبدالله أنّ النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم سئل عن( السَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ ) فقال: الكواكب، و سئل عن( الَّذِي جَعَلَ فِي السَّماءِ بُرُوجاً ) فقال: الكواكب. قيل:( بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ) فقال: قصور.
و فيه، أخرج عبد بن حميد و الترمذيّ و ابن أبي الدنيا في الاُصول و ابن جرير و ابن المنذر و ابن حاتم و ابن مردويه و البيهقيّ في سننه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : اليوم الموعود يوم القيامة و اليوم المشهود يوم عرفة و الشاهد يوم الجمعة. الحديث.
أقول: و روي مثله بطرق اُخرى عن أبي مالك و سعيد بن المسيّب و جبير بن مطعم عنهصلىاللهعليهوآلهوسلم ، و لفظ الأخير: الشاهد يوم الجمعة و المشهود يوم عرفة.
و روي هذا اللفظ عن عبدالرزّاق و الفاريابيّ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن عليّ بن أبي طالب.
و فيه، أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن عليّ قال: اليوم الموعود يوم القيامة، و الشاهد يوم الجمعة، و المشهود يوم النحر.
و في المجمع، روي: أنّ رجلاً دخل مسجد رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فإذا رجل يحدّث عن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم .
قال: فسألته عن الشاهد و المشهود فقال: نعم الشاهد يوم الجمعة و المشهود يوم عرفة، فجزته إلى آخر يحدّث عن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فسألته عن ذلك فقال: أمّا الشاهد فيوم الجمعة و أمّا المشهود فيوم النحر.
فجزتهما إلى غلام كأنّ وجهه الدينار و هو يحدّث عن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فقلت: أخبرني عن شاهد و مشهود فقال: نعم أمّا الشاهد فمحمّد و أمّا المشهود فيوم القيامة أ ما سمعت الله سبحانه يقول:( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً ) و قال:( ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ) .
فسألت عن الأوّل فقالوا: ابن عبّاس، و سألت عن الثاني فقالوا: ابن عمرو، و سألت عن الثالث فقالوا: الحسن بن علي.
أقول: و الحديث مرويّ بطرق مختلفة و ألفاظ متقاربة و قد تقدّم في تفسير الآية أنّ ما ذكرهعليهالسلام أظهر بالنظر إلى سياق الآيات، و إن كان لفظ الشاهد و المشهود لا يأبى الانطباق على غيره أيضاً بوجه.
و في تفسير القمّيّ: في قوله تعالى:( قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ ) قال: كان سببه أنّ الّذي هيّج الحبشة على غزوة اليمن ذو نواس و هو آخر من ملك من حمير تهوّد و اجتمعت معه حمير على اليهوديّة و سمّى نفسه يوسف و أقام على ذلك حيناً من الدهر.
ثمّ اُخبر أنّ بنجران بقايا قوم على دين النصرانيّة و كانوا على دين عيسى و حكم الإنجيل، و رأس ذلك الدين عبد الله بن بريامن فحمله أهل دينه على أن يسير إليهم و يحملهم على اليهوديّة و يدخلهم فيها فسار حتّى قدم نجران فجمع من كان
بها على دين النصرانيّة ثمّ عرض عليهم دين اليهوديّة و الدخول فيها فأبوا عليه فجادلهم و عرض عليهم و حرص الحرص كلّه فأبوا عليه و امتنعوا من اليهوديّة و الدّخول فيها و اختاروا القتل.
فاتّخذ لهم اُخدوداً و جمع فيه الحطب و أشعل فيه النار فمنهم من اُحرق بالنار و منهم من قتل بالسيف و مثل بهم كلّ مثلة فبلغ عدد من قتل و اُحرق بالنار عشرين ألفاً و أفلت منهم رجل يدعى دوش ذو ثعلبان على فرس له ركضة، و اتّبعوه حتّى أعجزهم في الرمل، و رجع ذو نواس إلى صنيعه في جنوده فقال الله:( قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ - إلى قوله -الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ) .
و في المجمع، و روى سعيد بن جبير قال: لمّا انهزم أهل إسفندهان قال عمر بن الخطّاب: ما هم يهود و لا نصارى و لا لهم كتاب و كانوا مجوساً فقال عليّ بن أبي طالب: بلى قد كان لهم كتاب رفع.
و ذلك أنّ ملكاً لهم سكر فوقع على ابنته - أو قال: على اُخته - فلمّا أفاق قال لها: كيف المخرج ممّا وقعت فيه؟ قالت: تجمع أهل مملكتك و تخبرهم أنّك ترى نكاح البنات و تأمرهم أن يحلّوه فجمعهم فأخبرهم فأبوا أن يتابعوه فخدّ لهم اُخدوداً في الأرض، و أوقد فيه النيران و عرضهم عليها فمن أبى قبول ذلك قذفه في النار، و من أجاب خلّى سبيله.
أقول: و روي هذا المعنى في الدرّ المنثور، عن عبد بن حميد عنهعليهالسلام .
و عن تفسير العيّاشيّ، بإسناده عن جابر عن أبي جعفرعليهالسلام قال: أرسل عليّعليهالسلام إلى اُسقفّ نجران يسأله عن أصحاب الاُخدود فأخبره بشيء فقالعليهالسلام : ليس كما ذكرت و لكن ساُخبرك عنهم:
إنّ الله بعث رجلاً حبشيّاً نبيّاً و هم حبشيّة فكذّبوه فقاتلهم فقتلوا أصحابه فأسروه و أسروا أصحابه ثمّ بنوا له حيراً ثمّ ملؤه ناراً ثمّ جمعوا الناس فقالوا: من كان على ديننا و أمرنا فليعتزل، و من كان على دين هؤلاء فليرم نفسه في النار فجعل أصحابه يتهافتون في النار فجاءت امرأة معها صبيّ لها ابن شهر فلمّا هجمت هابت و
رقّت على ابنها فنادى الصبيّ: لا تهابي و ارميني و نفسك في النار فإنّ هذا و الله في الله قليل، فرمت بنفسها في النار و صبيّها، و كان ممّن تكلّم في المهد.
أقول: و روي هذا المعنى في الدرّ المنثور، عن ابن مردويه عن عبدالله بن نجي عنهعليهالسلام ، و روي أيضاً عن ابن أبي حاتم من طريق عبدالله بن نجي عنهعليهالسلام قال: كان نبيّ أصحاب الاُخدود حبشيّاً.
و روي أيضاً عن ابن أبي حاتم و ابن المنذر من طريق الحسن عنهعليهالسلام في قوله تعالى:( أَصْحابُ الْأُخْدُودِ ) قال: هم الحبشة.
و لا يبعد أن يستفاد أنّ حديث أصحاب الاُخدود وقائع متعدّدة وقعت بالحبشة و اليمن و العجم و الإشارة في الآية إلى جميعها و هناك روايات تقصّ القصّة مع السكوت عن محلّ وقوعها.
و في تفسير القمّيّ: في قوله تعالى:( بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ) قال: اللوح المحفوظ له طرفان طرف على يمين العرش على جبين إسرافيل فإذا تكلّم الربّ جلّ ذكره بالوحي ضرب اللّوح جبين إسرافيل فنظر في اللّوح فيوحي بما في اللّوح إلى جبرئيل.
و في الدرّ المنثور، أخرج أبوالشيخ و ابن مردويه عن ابن عبّاس قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : خلق الله لوحاً من درّة بيضاء دفّتاه من زبرجدة خضراء كتابه من نور يلحظ إليه في كلّ يوم ثلاث مائة و ستّين لحظة يحيي و يميت و يخلق و يرزق و يعزّ و يذلّ و يفعل ما يشاء.
أقول: و الروايات في صفة اللوح كثيرة مختلفة و هي على نوع من التمثيل.
( سورة الطارق مكّيّة و هي سبع عشرة آية)
( سورة الطارق الآيات 1 - 17)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ( 1 ) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ( 2 ) النَّجْمُ الثَّاقِبُ ( 3 ) إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ( 4 ) فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ( 5 ) خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ ( 6 ) يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ( 7 ) إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ( 8 ) يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ( 9 ) فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ( 10 ) وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ( 11 ) وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ( 12 ) إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ( 13 ) وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ( 14 ) إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ( 15 ) وَأَكِيدُ كَيْدًا ( 16 ) فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ( 17 )
( بيان)
في السورة إنذار بالمعاد و تستدلّ عليه بإطلاق القدرة و تؤكّد القول في ذلك، و فيها إشارة إلى حقيقة اليوم، و تختتم بوعيد الكفّار.
و السورة ذات سياق مكّيّ.
قوله تعالى: ( وَ السَّماءِ وَ الطَّارِقِ وَ ما أَدْراكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ) الطرق في الأصل - على ما قيل - هو الضرب بشدّة يسمع له صوت و منه المطرقة و الطريق لأنّ السابلة تطرقها بأقدامها ثمّ شاع استعماله في سلوك الطريق ثمّ اختصّ بالإتيان ليلاً لأنّ الآتي بالليل في الغالب يجد الأبواب مغلقة فيطرقها و يدقّها ثمّ شاع الطارق
في كلّ ما يظهر ليلاً، و المراد بالطارق في الآية النجم الّذي يطلع بالليل.
و الثقب في الأصل بمعنى الخرق ثمّ صار بمعنى النيّر المضيء لأنّه يثقب الظلام بنوره و يأتي بمعنى العلوّ و الارتفاع و منه ثقب الطائر أي ارتفع و علا كأنّه يثقب الجوّ بطيرانه.
فقوله:( وَ السَّماءِ وَ الطَّارِقِ ) إقسام بالسماء و بالنجم الطالع ليلاً، و قوله:( وَ ما أَدْراكَ مَا الطَّارِقُ ) تفخيم لشأن المقسم به و هو الطارق، و قوله:( النَّجْمُ الثَّاقِبُ ) بيان للطارق و الجملة في معنى جواب استفهام مقدّر كأنّه لمّا قيل: و ما أدراك ما الطارق؟ سئل فقيل: فما هو الطارق؟ فاُجيب، و قيل: النجم الثاقب.
قوله تعالى: ( إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ ) جواب للقسم و لمّا بمعنى إلّا و المعنى ما من نفس إلّا عليها حافظ، و المراد من قيام الحافظ على حفظها كتابة أعمالها الحسنة و السيّئة على ما صدرت منها ليحاسب عليها يوم القيامة و يجزي بها فالحافظ هو الملك و المحفوظ العمل كما قال تعالى:( وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ كِراماً كاتِبِينَ يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونََ ) الانفطار: 12.
و لا يبعد أن يكون المراد من حفظ النفس حفظ ذاتها و أعمالها، و المراد بالحافظ جنسه فتفيد أنّ النفوس محفوظة لا تبطل بالموت و لا تفسد حتّى إذا أحيا الله الأبدان أرجع النفوس إليها فكان الإنسان هو الإنسان الدنيويّ بعينه و شخصه ثمّ يجزيه بما يقتضيه أعماله المحفوظة عليه من خير أو شرّ.
و يؤيّد ذلك كثير من الآيات الدالّة على حفظ الأشياء كقوله تعالى:( قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ) الم السجدة: 11، و قوله:( اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَ الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ ) الزمر: 42.
و لا ينافي هذا الوجه ظاهر آية الانفطار السابقة من أنّ حفظ الملائكة هو الكتابة فإنّ حفظ نفس الإنسان أيضاً من الكتابة على ما يستفاد من قوله:( إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) الجاثية: 29 و قد تقدّمت الإشارة إليه.
و يندفع بهذا الوجه الاعتراض على ما استدلّ به على المعاد من إطلاق القدرة كما سيجيء، و محصّله أنّ إطلاق القدرة إنّما ينفع فيما كان ممكناً لكن إعادة الإنسان بعينه محال فإنّ الإنسان المخلوق ثانياً مثل الإنسان الدنيويّ المخلوق أوّلاً لا شخصه الّذي خلق أوّلاً و مثل الشيء غير الشيء لا عينه.
وجه الاندفاع أنّ شخصيّة الشخص من الإنسان بنفسه لا ببدنه و النفس محفوظة فإذا خلق البدن و تعلّقت به النفس كان هو الإنسان الدنيويّ بشخصه و إن كان البدن بالقياس إلى البدن مع الغضّ عن النفس، مثلاً لا عيناً.
قوله تعالى: ( فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ ) أي ما هو مبدأ خلقه؟ و ما هو الّذي صيّره الله إنساناً؟
و الجملة متفرّعة على الآية السابقة و ما تدلّ عليه بفحواها بحسب السياق و محصّل المعنى و إذ كانت كلّ نفس محفوظة بذاتها و عملها من غير أن تفنى أو ينسى عملها فليذعن الإنسان أن سيرجع إلى ربّه و يجزي بما عمل و لا يستبعد ذلك و لينظر لتحصيل هذا الإذعان إلى مبدإ خلقه و يتذكّر أنّه خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب و الترائب.
فالّذي بدأ خلقه من ماء هذه صفته يقدر على رجعه و إحيائه بعد الموت.
و في الإتيان بقوله:( خُلِقَ ) مبنيّاً للمفعول و ترك ذكر الفاعل و هو الله سبحانه إيماء إلى ظهور أمره، و نظيره قوله:( خُلِقَ مِنْ ماءٍ ) إلخ.
قوله تعالى: ( خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ ) الدفق تصبّب الماء و سيلانه بدفع و سرعة و الماء الدافق هو المنيّ و الجملة جواب عن استفهام مقدّر يهدي إليه قوله:( مِمَّ خُلِقَ ) .
قوله تعالى: ( يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرائِبِ ) الصلب الظهر، و الترائب جمع تريبة و هي عظم الصدر.
و قد اختلفت كلماتهم في الآية و ما قبلها اختلافاً عجيباً، و الظاهر أنّ المراد بقوله:( بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرائِبِ ) البعض المحصور من البدن بين جداري عظام الظهر و
عظام الصدر(1) .
قوله تعالى: ( إِنَّهُ عَلى رَجْعِهِ لَقادِرٌ ) الرجع الإعادة، و ضمير( إِنَّهُ ) له تعالى و اكتفى بالإضمار مع أنّ المقام مقام الإظهار لظهوره نظير قوله:( خُلِقَ ) مبنيّاً للمفعول.
و المعنى أنّ الّذي خلق الإنسان من ماء صفته تلك الصفة، على إعادته و إحيائه بعد الموت - و إعادته مثل بدئه - لقادر لأنّ القدرة على الشيء قدرة على مثله إذ حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد.
قوله تعالى: ( يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ ) ظرف للرجع، و السريرة ما أسرّه الإنسان و أخفاه في نفسه، و البلاء الاختبار و التعرّف و التصفّح.
فالمعنى يوم يختبر ما أخفاه الإنسان و أسرّه من العقائد و آثار الأعمال خيرها و شرّها فيميّز خيرها من شرّها و يجزي الإنسان به فالآية في معنى قوله تعالى:( إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ ) البقرة: 284.
قوله تعالى: ( فَما لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَ لا ناصِرٍ ) أي لا قدرة له في نفسه يمتنع بها من عذاب الله و لا ناصر له يدفع عنه ذلك أي لا قدرة هناك يدفع عنه الشرّ لا من نفسه و لا من غيره.
قوله تعالى: ( وَ السَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ وَ الْأَرْضِ ذاتِ الصَّدْعِ ) إقسام بعد إقسام لتأكيد أمر القيامة و الرجوع إلى الله.
و المراد بكون السماء ذات رجع ما يظهر للحسّ من سيرها بطلوع الكواكب بعد غروبها و غروبها بعد طلوعها، و قيل: رجعها أمطارها، و المراد بكون الأرض ذات صدع تصدّعها و انشقاقها بالنبات، و مناسبة القسمين لما اُقسم عليه من الرجوع بعد الموت و الخروج من القبور ظاهرة.
قوله تعالى: ( إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَ ما هُوَ بِالْهَزْلِ ) الفصل إبانة أحد الشيئين من
____________________
(1) و قد أورد المراغي في تفسيره في ذيل الآية عن بعض الأطباء توجيهاً دقيقاً علميّاً لهذه الآية من أراده فليراجعه.
الآخر حتّى يكون بينهما فرجة، و التعبير بالفصل - و المراد الفاصل - للمبالغة كزيد عدل و الهزل خلاف الجدّ.
و الآيتان جواب القسم، و ضمير( إِنَّهُ ) للقرآن و المعنى اُقسم بكذا و كذا إنّ القرآن لقول فاصل بين الحقّ و الباطل و ليس هو كلاماً لا جدّ فيه فما يُحقّه حقّ لا ريب فيه و ما يبطله باطل لا ريب فيه فما أخبركم به من البعث و الرجوع حقّ لا ريب فيه.
و قيل: الضمير لما تقدّم من خبر الرجوع و المعاد، و الوجه السابق أوجه.
قوله تعالى: ( إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً وَ أَكِيدُ كَيْداً ) أي الكفّار يحتالون بكفرهم و إنكارهم المعاد احتيالاً يريدون به إطفاء نور الله و إبطال دعوتك، و احتال عليهم بعين أعمالهم بالاستدراج و الإملاء و الإضلال بالطبع على قلوبهم و جعل الغشاوة على سمعهم و أبصارهم احتيالاً أسوقهم به إلى عذاب يوم القيامة.
قوله تعالى: ( فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً ) التمهيل و الإمهال بمعنى واحد غير أنّ باب التفعيل يفيد التدريج و الإفعال يفيد الدفعة، و الرويد القليل.
و المعنى: إذا كان منهم كيد و منّي كيد عليهم بعين ما يكيدون به و الله غالب على أمره، فانتظر بهم و لا تعاجلهم انتظر بهم قليلاً فسيأتيهم ما اُوعدهم به فكلّ ما هو آت قريب.
و في التعبير أوّلاً بمهّل الظاهر في التدريج و ثانياً مع التقييد برويداً بأمهل الظاهر في الدفعة لطف ظاهر.
( بحث روائي)
في تفسير القمّيّ: في قوله تعالى:( إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ ) قال: الملائكة.
و فيه: في قوله تعالى:( خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ ) قال: النطفة الّتي تخرج بقوّة.
و فيه: في قوله تعالى:( يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرائِبِ ) قال: الصلب الرجل
و الترائب المرأة، و هو صدرها.
أقول: الرواية على إضمارها و إرسالها لا تخلو من شيء.
و فيه: في قوله تعالى:( يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ ) قال: يكشف عنها.
و في المجمع، روي مرفوعاً عن أبي الدرداء قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : ضمن الله خلقه أربع خصال: الصلاة، و الزكاة، و صوم شهر رمضان، و الغسل من الجنابة، و هي السرائر الّتي قال الله تعالى: يوم تبلى السرائر.
أقول: و لعلّه من قبيل ذكر بعض المصاديق كما تؤيّده الرواية التالية.
و فيه، عن معاذ بن جبل قال: سألت رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : ما هذه السرائر الّتي ابتلى الله بها العباد في الآخرة؟ فقال: سرائركم هي أعمالكم من الصلاة و الصيام و الزكاة و الوضوء و الغسل من الجنابة و كلّ مفروض لأنّ الأعمال كلّها سرائر خفيّة فإن شاء الرجل قال: صلّيت و لم يصلّ و إن شاء قال: توضّيت و لم يتوضّ فذلك قوله:( يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ ) .
و في تفسير القمّيّ: في قوله تعالى:( فَما لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَ لا ناصِرٍ ) قال: ما له من قوّة يهوي بها على خالقه، و لا ناصر من الله ينصره إن أراد به سوءا.
و فيه: في قوله تعالى:( وَ السَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ ) قال: ذات المطر( وَ الْأَرْضِ ذاتِ الصَّدْعِ ) أي ذات النبات.
و في المجمع:( إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ) يعني أنّ القرآن يفصل بين الحقّ و الباطل بالبيان عن كلّ واحد منهما، و روي ذلك عن الصادقعليهالسلام .
و في الدرّ المنثور، أخرج ابن أبي شيبة و الدارميّ و الترمذيّ و محمّد بن نصر و ابن الأنباريّ في المصاحف عن الحارث الأعور قال: دخلت المسجد فإذا الناس قد وقعوا في الأحاديث فأتيت عليّاً فأخبرته فقال: أ و قد فعلوها؟
سمعت رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم يقول: إنّها ستكون فتنة. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله قال: كتاب الله فيه نبأ من قبلكم و خبر من بعدكم، و حكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبّار قصمه الله، من ابتغى الهوى في غيره أضلّه الله، و هو حبل الله
المتين، و هو الذكر الحكيم، و هو الصراط المستقيم، هو الّذي لا تزيغ به الأهواء، و لا يشبع منه العلماء، و لا تلتبس منه الألسن، و لا يخلق من الردّ، و لا تنقضي عجائبه هو الّذي لم ينته الجنّ إذ سمعته حتّى قالوا( إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ ) . من قال به صدق، و من حكم به عدل، و من عمل به اُجر، و من دعي إليه هدي إلى صراط مستقيم.
أقول: و روي ما يقرب منه عن معاذ بن جبل عنهصلىاللهعليهوآلهوسلم ، و رواه مختصراً عن ابن مردويه عن عليّعليهالسلام .
( سورة الأعلى مكّيّة و هي تسع عشرة آية)
( سورة الأعلى الآيات 1 - 19)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ( 1 ) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ( 2 ) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ( 3 ) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ ( 4 ) فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ ( 5 ) سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ ( 6 ) إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ( 7 ) وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ( 8 ) فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ ( 9 ) سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ ( 10 ) وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ( 11 ) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ( 12 ) ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ( 13 ) قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ( 14 ) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ( 15 ) بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ( 16 ) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ( 17 ) إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ( 18 ) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ( 19 )
( بيان)
أمرٌ بتوحيده تعالى على ما يليق بساحته المقدّسة و تنزيه ذاته المتعالية من أن يذكر مع اسمه اسم غيره أو يسند إلى غيره ما يجب أن يسند إليه كالخلق و التدبير و الرزق و وعد لهصلىاللهعليهوآلهوسلم بتأييده بالعلم و الحفظ و تمكينه من الطريقة الّتي هي أسهل و أيسر للتبليغ و أنسب للدعوة.
و سياق الآيات في صدر السورة سياق مكّيّ و أمّا ذيلها أعني قوله:( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ) إلخ فقد ورد من طرق أئمّة أهل البيتعليهمالسلام و كذا من طريق أهل السنّة
أنّ المراد به زكاة الفطرة و صلاة العيد و من المعلوم أنّ الصوم و ما يتبعه من زكاة الفطرة و صلاة العيد إنّما شرعت بالمدينة بعد الهجرة فتكون آيات الذيل نازلة بالمدينة.
فالسورة صدرها مكّيّ و ذيلها مدنيّ، و لا ينافي ذلك ما جاء في الآثار أنّ السورة مكّيّة فإنّه لا يأبى الحمل على صدر السورة.
قوله تعالى: ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) أمر بتنزيه اسمه تعالى و تقديسه، و إذ علّق التنزيه على الاسم - و ظاهر اللفظ الدالّ على المسمّى - و الاسم إنّما يقع في القول فتنزيهه أن لا يذكر معه ما هو تعالى منزّه عنه كذكر الآلهة و الشركاء و الشفعاء و نسبة الربوبيّة إليهم و كذكر بعض ما يختصّ به تعالى كالخلق و الإيجاد و الرزق و الإحياء و الإماتة و نحوها و نسبته إلى غيره تعالى أو كذكر بعض ما لا يليق بساحة قدسه تعالى من الأفعال كالعجز و الجهل و الظلم و الغفلة و ما يشبهها من صفات النقص و الشين و نسبته إليه تعالى.
و بالجملة تنزيه اسمه تعالى أن يجرّد القول عن ذكر ما لا يناسب ذكره ذكر اسمه تعالى و هو تنزيهه تعالى في مرحلة القول الموافق لتنزيهه في مرحلة الفعل.
و هو يلازم التوحيد الكامل بنفي الشرك الجليّ كما في قوله:( وَ إِذا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَ إِذا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ) الزمر: 45 و قوله:( وَ إِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى أَدْبارِهِمْ نُفُوراً ) إسراء: 46.
و في إضافة الاسم إلى الربّ و الربّ إلى ضمير الخطاب تأييد لما قدّمناه فإنّ المعنى سبّح اسم ربّك الّذي اتّخذته ربّاً و أنت تدعو إلى أنّه الربّ الإله فلا يقعنّ في كلامك مع ذكر اسمه بالربوبيّة ذكر من غيره بحيث ينافي تسمّيه بالربوبيّة على ما عرّف نفسه لك.
و قوله:( الْأَعْلَى ) و هو الّذي يعلو كلّ عال و يقهر كلّ شيء صفة( رَبِّكَ ) دون الاسم و يعلّل بمعناه الحكم أي سبّح اسمه لأنّه أعلى.
و قيل: معنى( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) قل: سبحان ربّي الأعلى كما عن ابن عبّاس و نسب إليه أيضاً أنّ المعنى صلّ.
و قيل: المراد بالاسم المسمّى و المعنى نزّهه تعالى عن كلّ ما لا يليق بساحة قدسه من الصفات و الأفعال.
و قيل: إنّه ذكر الاسم و المراد به تعظيم المسمّى و استشهد عليه بقول لبيد، إلى الحول ثمّ اسم السلام عليكما. فالمعنى سبّح ربّك الأعلى.
و قيل: المراد تنزيه أسمائه تعالى عمّا لا يليق بأن لا يؤوّل ممّا ورد منها اسم من غير مقتض، و لا يبقى على ظاهره إذا كان ما وضع له لا يصحّ له تعالى، و لا يطلقه على غيره تعالى إذا كان مختصّاً كاسم الجلالة و لا يتلفّظ به في محلّ لا يناسبه كبيت الخلاء، و على هذا القياس.
و ما قدّمناه من المعنى أوسع و أشمل و أنسب لسياق قوله الآتي( سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى ) ( وَ نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرى فَذَكِّرْ ) فإنّ السياق سياق البعث إلى التذكرة و التبليغ فبدأ أوّلاً بإصلاح كلامهصلىاللهعليهوآلهوسلم و تجريده عن كلّ ما يشعر بجليّ الشرك و خفيّه بأمره بتنزيه اسم ربّه، و وعد ثانياً بإقرائه بحيث لا ينسى شيئاً ممّا اُوحي إليه و تسهيل طريقة التبليغ عليه ثمّ اُمر بالتذكير و التبليغ فافهم.
قوله تعالى: ( الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ) خلق الشيء جمع أجزائه، و تسويته جعلها متساوية بحيث يوضع كلّ في موضعه الّذي يليق به و يعطى حقّه كوضع كلّ عضو من أعضاء الإنسان فيما يناسبه من الموضع.
و الخلق و التسوية و إن كانا مطلقين لكنّهما إنّما يشملان ما فيه تركيب أو شائبة تركيب من المخلوقات.
و الآية إلى تمام أربع آيات تصف التدبير الإلهيّ و هي برهان على ربوبيّته تعالى المطلقة.
قوله تعالى: ( وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدى ) أي جعل الأشياء الّتي خلقها على مقادير مخصوصة و حدود معيّنة في ذواتها و صفاتها و أفعالها لا تتعدّاها و جهّزها بما يناسب
ما قدّر لها فهداها إلى ما قدّر فكلّ يسلك نحو ما قدّر له بهداية ربّانيّة تكوينيّة كالطفل يهتدي إلى ثدي اُمّه و الفرخ إلى زقّ اُمّه و أبيه، و الذكر إلى الاُنثى و ذي النفع إلى نفعه و على هذا القياس.
قال تعالى:( وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ) الحجر: 21، و قال:( ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ) عبس: 20 و قال:( لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها ) البقرة: 148.
قوله تعالى: ( وَ الَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعى ) المرعى ما ترعاه الدوابّ فالله تعالى هو الّذي أخرجها أي أنبتها.
قوله تعالى: ( فَجَعَلَهُ غُثاءً أَحْوى ) الغثاء ما يقذفه السيل على جانب الوادي من الحشيش و النبات، و المراد هنا - كما قيل - اليابس من النبات، و الأحوى الأسود.
و إخراج المرعى لتغذّي الحيوان ثمّ جعله غثاء أحوى من مصاديق التدبير الربوبيّ و دلائله كما أنّ الخلق و التسوية و التقدير و الهداية كذلك.
قوله تعالى: ( سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى إِلَّا ما شاءَ اللهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ ما يَخْفى ) قال في المفردات: و القراءة ضمّ الحروف و الكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل، و ليس يقال ذلك لكلّ جمع لا يقال: قرأت القوم إذا جمعتهم، و يدلّ على ذلك أنّه لا يقال للحرف الواحد إذا تفوّه به قراءة، انتهى، و قال في المجمع: و الإقراء أخذ القراءة على القارئ بالاستماع لتقويم الزلل، و القارئ التالي. انتهى.
و ليس إقراؤه تعالى نبيّهصلىاللهعليهوآلهوسلم القرآن مثل إقراء بعضنا بعضاً باستماع المقري لما يقرؤه القارئ و إصلاح ما لا يحسنه أو يغلط فيه فلم يعهد من النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم أن يقرأ شيئاً من القرآن فلا يحسنه أو يغلط فيه عن نسيان للوحي ثمّ يقرأ فيصلح بل المراد تمكينه من قراءة القرآن كما اُنزل من غير أن يغيّره بزيادة أو نقص أو تحريف بسبب النسيان.
فقوله:( سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى ) وعدٌ منه لنبيّهصلىاللهعليهوآلهوسلم أن يمكّنه من العلم
بالقرآن و حفظه على ما اُنزل بحيث يرتفع عنه النسيان فيقرؤه كما اُنزل و هو الملاك في تبليغ الوحي كما اُوحي إليه.
و قوله:( إِلَّا ما شاءَ اللهُ ) استثناء مفيد لبقاء القدرة الإلهيّة على إطلاقها و أنّ هذه العطيّة و هي الإقراء بحيث لا تنسى لا ينقطع عنه سبحانه بالإعطاء بحيث لا يقدر بعد على إنسائك بل هو باق على إطلاق قدرته له أن يشاء إنساءك متى شاء و إن كان لا يشاء ذلك فهو نظير الاستثناء الّذي في قوله:( وَ أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ) هود: 108 و قد تقدّم توضيحه.
و ليس المراد بالاستثناء إخراج بعض أفراد النسيان من عموم النفي و المعنى سنقرئك فلا تنسى شيئاً إلّا ما شاء الله أن تنساه و ذلك أنّ كلّ إنسان على هذه الحال يحفظ أشياء و ينسى أشياء فلا معنى لاختصاصه بالنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم بلحن الامتنان مع كونه مشتركاً بينه و بين غيره فالوجه ما قدّمناه.
و الآية بسياقها لا تخلو من تأييد لما قيل: إنّه كان النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي يقرؤه مخافة أن ينساه فكان لا يفرغ جبريل من آخر الوحي حتّى يتكلّم هو بأوّله فلمّا نزلت هذه الآية لم ينس بعده شيئاً.
و يقرب من الاعتبار أن تكون هذه الآية أعني قوله:( سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى ) نازلة أوّلاً ثمّ قوله:( لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ ) القيامة: 19 ثمّ قوله:( وَ لا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً ) طه: 114.
و قوله:( إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ ما يَخْفى ) الجهر كمال ظهور الشيء لحاسّة البصر كقوله:( فَقالُوا أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً ) النساء: 153، أو لحاسّة السمع كقوله:( إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ ) الأنبياء: 110، و المراد بالجهر الظاهر للإدراك بقرينة مقابلته لقوله:( وَ ما يَخْفى ) من غير تقييده بسمع أو بصر.
و الجملة في مقام التعليل لقوله:( سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى ) و المعنى سنصلح لك بالك
في تلقّي الوحي و حفظه لأنّا نعلم ظاهر الأشياء و باطنها فنعلم ظاهر حالك و باطنها و ما أنت عليه من الاهتمام بأمر الوحي و الحرص على طاعته فيما أمر به.
و في قوله:( إِلَّا ما شاءَ اللهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ ) إلخ التفات من التكلّم مع الغير إلى الغيبة و النكتة فيه الإشارة إلى حجّة الاستثناء فإفاضة العلم و الحفظ للنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم إنّما لا يسلب القدرة على خلافه و لا يحدّها منه تعالى لأنّه الله المستجمع لجميع صفات الكمال و منها القدرة المطلقة ثمّ جرى الالتفات في قوله:( إِنَّهُ يَعْلَمُ ) إلخ لمثل النكتة.
قوله تعالى: ( وَ نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرى ) اليسرى - مؤنث أيسر - و هو وصف قائم مقام موصوفة المحذوف أي الطريقة اليسرى و التيسير التسهيل أي و نجعلك بحيث تتّخذ دائماً أسهل الطرق للدعوة و التبليغ قولاً و فعلاً فتهدي قوماً و تتمّ الحجّة على آخرين و تصبر على أذاهم.
و كان مقتضى الظاهر أن يقال: و نيسّر لك اليسرى كما قال:( وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي ) طه: 26 و إنّما عدل عن ذلك إلى قوله:( وَ نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرى ) لأنّ الكلام في تجهيزه تعالى نفس النبيّ الشريفة و جعله إيّاها صالحة لتأدية الرسالة و نشر الدعوة. على ما في نيسّر اليسرى من إيهام تحصيل الحاصل.
فالمراد جعلهصلىاللهعليهوآلهوسلم صافي الفطرة حقيقاً على اختيار الطريقة اليسرى الّتي هي طريقة الفطرة فالآية في معنى قوله حكاية عن موسى:( حَقِيقٌ عَلى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ ) الأعراف: 105.
قوله تعالى: ( فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى ) تفريع على ما تقدّم من أمرهصلىاللهعليهوآلهوسلم بتنزيه اسم ربّه و وعده إقراء الوحي بحيث لا ينسى و تيسيره لليسرى و هي الشرائط الضروريّة الّتي يتوقّف عليها نجاح الدعوة الدينيّة.
و المعنى إذ تمّ لك الأمر بامتثال ما أمرناك به و إقرائك فلا تنسى و تيسيرك لليسرى فذكّر إن نفعت الذكرى.
و قد اشترط في الأمر بالتذكرة أن تكون نافعة و هو شرط على حقيقته فإنّها إذا
لم تنفع كانت لغواً و هو تعالى يجلّ عن أن يأمر باللّغو فالتذكرة لمن يخشى لأوّل مرّة تفيد ميلا من نفسه إلى الحقّ و هو نفعها و كذا التذكرة بعد التذكرة كما قال:( سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشى ) و التذكرة للأشقى الّذي لا خشية في قلبه لأوّل مرّة تفيد تمام الحجّة عليه و هو نفعها و يلازمها تجنّبه و تولّيه عن الحقّ كما قال:( يَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ) و التذكرة بعد التذكرة له لا تنفع شيئاً و لذا اُمر بالإعراض عن ذلك قال تعالى:( فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنا وَ لَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَياةَ الدُّنْيا ) النجم: 29.
و قيل: الشرط شرط صوريّ غير حقيقيّ و إنّما هو إخبار عن أنّ الذكرى نافعة لا محالة في زيادة الطاعة و الانتهاء عن المعصية كما يقال: سله إن نفع السؤال و لذا قال بعضهم( إن ) ( إِنْ ) في الآية بمعنى قد، و قال آخرون: إنّها بمعنى إذ.
و فيه أنّ كون الذكرى نافعة مفيدة دائماً حتّى فيمن يعاند الحقّ - و قد تمّت عليه الحجّة - ممنوع كيف؟ و قد قيل فيهم:( سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ عَلى سَمْعِهِمْ وَ عَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ ) البقرة: 7.
و قيل: إنّ في الكلام إيجازاً بالحذف، و التقدير فذكّر إن نفعت الذكرى و إن لم تنفع و ذلك لأنّهصلىاللهعليهوآلهوسلم بعث للتذكرة و الإعذار فعليه أن يذكّر نفع أو لم ينفع فالآية من قبيل قوله:( وَ جَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ ) النحل: 81 أي و البرد.
و فيه أنّ وجوب التذكرة عليهصلىاللهعليهوآلهوسلم حتّى فيما لا يترتّب عليها أثراً أصلاً ممنوع.
و قيل: إنّ الشرط مسوق للإشارة إلى استبعاد النفع في تذكرة هؤلاء المذكورين نعياً عليهم كأنّه قيل: افعل ما اُمرت به لتوجر و إن لم ينتفعوا به.
و فيه أنّه يردّه قوله تعالى بعده بلا فصل:( سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشى ) .
قوله تعالى: ( سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشى ) أي سيتذكّر و يتّعظ بالقرآن من في قلبه شيء من خشية الله و خوف عقابه.
قوله تعالى: ( يَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ) الضمير للذكرى و المراد بالأشقى بقرينة
المقابلة من ليس في قلبه شيء من خشية الله تعالى، و تجنّب الشيء التباعد عنه، و المعنى و سيتباعد عن الذكرى من لا يخشى الله.
قوله تعالى: ( الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرى ) الظاهر أنّ المراد بالنار الكبرى نار جهنّم و هي نار كبري بالقياس إلى نار الدنيا، و قيل: المراد بها أسفل دركات جهنّم و هي أشدّها عذاباً.
قوله تعالى: ( ثُمَّ لا يَمُوتُ فِيها وَ لا يَحْيى ) ثمّ للتراخي بحسب رتبة الكلام، و المراد من نفي الموت و الحياة عنه معاً نفي النجاة نفياً مؤبّداً فإنّ النجاة بمعنى انقطاع العذاب بأحد أمرين إمّا بالموت حتّى ينقطع عنه العذاب بانقطاع وجوده و إمّا يتبدّل صفة الحياة من الشقاء إلى السعادة و من العذاب إلى الراحة فالمراد بالحياة في الآية الحياة الطيّبة على حدّ قولهم في الحرض: لا حيّ فيرجى و لا ميّت فينسى.
قوله تعالى: ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ) التزكّي هو التطهّر و المراد به التطهّر من ألواث التعلّقات الدنيويّة الصارفة عن الآخرة بدليل قوله بعد( بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا ) إلخ، و الرجوع إلى الله بالتوجّه إليه تطهّر من الإخلاد إلى الأرض، و الإنفاق في سبيل الله تطهّر من لوث التعلّق الماليّ حتّى أنّ وضوء الصلاة تمثيل للتطهّر عمّا كسبته الوجوه و الأيدي و الأقدام.
و قوله:( وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ) الظاهر أنّ المراد بالذكر الذكر اللفظيّ، و بالصلاة التوجّه الخاصّ المشروع في الإسلام.
و الآيتان بحسب ظاهر مدلولهما على العموم لكن ورد في المأثور عن أئمّة أهل البيتعليهمالسلام أنّهما نزلتا في زكاة الفطر و صلاة العيد و كذا من طرق أهل السنّة.
قوله تعالى: ( بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا ) إضراب بالخطاب لعامّة الناس على ما يدعو إليه طبعهم البشريّ من التعلّق التامّ بالدنيا و الاشتغال بتعميرها، و الإيثار الاختيار، و قيل: الخطاب للكفّار، و الكلام على أيّ حال مسوق للعتاب و الالتفات لتأكيده.
قوله تعالى: ( وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقى ) عدّ الآخرة أبقى بالنسبة إلى الدنيا مع أنّها باقية أبديّة في نفسها لأنّ المقام مقام الترجيح بين الدنيا و الآخرة و يكفي في الترجيح مجرّد كون الآخرة خيراً و أبقى بالنسبة إلى الدنيا و إن قطع النظر عن كونها باقية أبديّة.
قوله تعالى: ( إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى ) الإشارة بهذا إلى ما بين في قوله:( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ) إلى تمام أربع آيات، و قيل: هذا إشارة إلى مضمون قوله:( وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقى ) .
قيل: و في إبهام الصحف و وصفها بالتقدّم أوّلاً ثمّ بيانها و تفسيرها بصحف إبراهيم و موسى ثانياً ما لا يخفى من تفخيم شأنها و تعظيم أمرها.
( بحث روائي)
في تفسير العيّاشيّ، عن عقبة بن عامر الجهنيّ قال: لمّا نزلت:( فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ) قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : اجعلوها في ركوعكم، و لمّا نزل( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) قال: اجعلوها في سجودكم.
أقول: و رواه أيضاً في الدرّ المنثور، عن أحمد و أبي داود و ابن ماجة و ابن المنذر و ابن مردويه عن عقبة عنهصلىاللهعليهوآلهوسلم .
و في تفسير القمّيّ:( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) قال: قل سبحان ربّي الأعلى( الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدى ) قال: قدّر الأشياء بالتقدير الأوّل ثمّ هدى إليها من يشاء.
و فيه: في قوله تعالى:( وَ الَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعى ) قال: أي النبات. و في قوله:( غُثاءً أَحْوى ) قال: يصير هشيماً بعد بلوغه و يسودّ.
و في الدرّ المنثور، أخرج ابن مردويه عن ابن عبّاس قال: كان النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم يستذكر القرآن مخافة أن ينساه فقيل له: كفيناك ذلك و نزلت:( سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى ) .
و في الفقيه: و سئل الصادقعليهالسلام عن قول الله عزّوجلّ:( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ) قال قال: من أخرج الفطرة قيل له: و( ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ) قال: خرج إلى الجبانة(1) فصلّى.
أقول: و روي هذا المعنى أيضاً عن حمادّ عن جرير عن أبي بصير و زرارة عنهعليهالسلام و رواه القمّيّ في تفسيره، مرسلاً مضمراً.
و في الدرّ المنثور، أخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدريّ قال: كان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم يقول:( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ) ثمّ يقسّم الفطرة قبل أن يغدو إلى المصلّى يوم الفطر.
أقول: و روي أيضاً نزول الآيتين في زكاة الفطرة و صلاة العيد بطريقين عن أبي سعيد موقوفاً، و كذا بطريقين عن ابن عمر و بطريق عن نائلة بن الأصقع و بطريقين عن أبي العالية و بطريق عن عطاء و بطريق عن محمّد بن سيرين و بطريق عن إبراهيم النخعي و كذا عن عمرو بن عوف عن النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم .
و في الخصال، عن عتبة بن عمرو الليثيّ عن أبي ذرّ في حديث قلت: يا رسول الله فما في الدنيا ممّا أنزل الله عليك شيء ممّا كان في صحف إبراهيم و موسى؟ قال: يا أبا ذرّ اقرأ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقى إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى ) .
أقول: يؤيّد الحديث كون الإشارة بهذا إلى مجموع الآيات الأربع كما تقدّم.
و في البصائر، بإسناده عن أبي بصير قال: قال أبوعبداللهعليهالسلام : عندنا الصحف الّتي قال الله:( صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى ) قلت: الصحف هي الألواح؟ قال: نعم.
أقول: و رواه أيضاً بطريق آخر عن أبي بصير عنهعليهالسلام و الظاهر أنّ المراد بكون الصحف هي الألواح كونها هي التوراة المعبّر عنها في مواضع من القرآن بالألواح كقوله تعالى:( وَ كَتَبْنا لَهُ فِي الْأَلْواحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ) الأعراف: 145 و قوله:( وَ أَلْقَى
____________________
(1) الجبانة: الصحراء
الْأَلْواحَ ) الأعراف: 150 و قوله:( أَخَذَ الْأَلْواحَ ) الأعراف: 154.
و في المجمع، روي عن أبي ذرّ أنّه قال: قلت: يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: مائة ألف نبيّ و أربعة و عشرون ألفاً قلت: يا رسول الله كم المرسلون منهم؟ قال: ثلاث مائة و ثلاثة عشر و بقيّتهم أنبياء. قلت: كان آدم نبيّاً؟ قال: نعم كلّمة الله و خلقه بيده.
يا أبا ذرّ أربعة من الأنبياء عرب: هود و صالح و شعيب و نبيّك.
قلت: يا رسول الله كم أنزل الله من كتاب؟ قال: مائة و أربعة كتب اُنزل منها على آدم عشرة صحف، و على شيث خمسين صحيفة، و على اُخنوخ و هو إدريس ثلاثين صحيفة و هو أوّل من خطّ بالقلم و على إبراهيم عشر صحائف و التوراة و الإنجيل و الزبور و الفرقان.
أقول: و روي ذلك في الدرّ المنثور، عن عبد بن حميد و ابن مردويه و ابن عساكر عن أبي ذرّ غير أنّه لم يذكر صحف آدم و ذكر لموسى عشر صحف قبل التوراة.
( سورة الغاشية مكّيّة و هي ستّ و عشرون آية)
( سورة الغاشية الآيات 1 - 26)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ( 1 ) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ( 2 ) عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ( 3 ) تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ( 4 ) تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ ( 5 ) لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ( 6 ) لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ( 7 ) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ( 8 ) لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ( 9 ) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ( 10 ) لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ( 11 ) فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ( 12 ) فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ( 13 ) وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ( 14 ) وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ( 15 ) وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ( 16 ) أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ( 17 ) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ( 18 ) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ( 19 ) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ( 20 ) فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ( 21 ) لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ( 22 ) إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ( 23 ) فَيُعَذِّبُهُ اللهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ( 24 ) إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ( 25 ) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ( 26 )
( بيان)
سورة إنذار و تبشير تصف الغاشية و هي يوم القيامة الّذي يحيط بالناس تصفه بحال الناس فيه من حيث انقسامهم فريقين: السعداء و الأشقياء و استقرارهم فيما اُعدّ لهم من الجنّة و النار و تنتهي إلى أمرهصلىاللهعليهوآلهوسلم أن يذكّر الناس بفنون من التدبير الربوبيّ
في العالم الدالّة على ربوبيّته تعالى لهم و رجوعهم إليه لحساب أعمالهم.
و السورة مكّيّة بشهادة سياق آياتها.
قوله تعالى: ( هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ ) استفهام بداعي التفخيم و الإعظام، و المراد بالغاشية يوم القيامة سمّيت بذلك لأنّها تغشى الناس و تحيط بهم كما قال:( وَ حَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً ) الكهف: 47، أو لأنّها تغشى الناس بأهوالها بغتة كما قيل، أو لأنّها تغشى وجوه الكفّار بالعذاب.
قوله تعالى: ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ ) أي مذلّلة بالغمّ و العذاب يغشاها، و الخشوع إنّما هو لأرباب الوجوه و إنّما نسب إلى الوجوه لأنّ الخشوع و المذلّة يظهر فيها.
قوله تعالى: ( عامِلَةٌ ناصِبَةٌ ) النصب التعب و( عامِلَةٌ ) خبر بعد خبر لوجوه، و كذا قوله:( ناصِبَةٌ ) و( تَصْلى ) و( تُسْقى ) و( لَيْسَ لَهُمْ ) و المراد من عملها و نصبها بقرينة مقابلتهما في صفة أهل الجنّة الآتية بقوله:( لِسَعْيِها راضِيَةٌ ) عملها في الدنيا و نصبها في الآخرة فإنّ الإنسان إنّما يعمل ما يعمل في الدنيا ليسعد به و يظفر بالمطلوب لكن عملهم خبط باطل لا ينفعهم شيئاً كما قال تعالى:( وَ قَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً ) الفرقان: 23 فلا يعود إليهم من عملهم إلّا النصب و التعب بخلاف أهل الجنّة فإنّهم لسعيهم الّذي سعوه في الدنيا راضون لما ساقهم إلى الجنّة و الراحة.
و قيل: المراد أنّها عاملة في النار ناصبة فيها فهي تعالج أنواع العذاب الّذي تعذّب به و تتعب لذلك.
و قيل: المراد أنّها عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في النار يوم القيامة.
قوله تعالى: ( تَصْلى ناراً حامِيَةً ) أي تلزم ناراً في نهاية الحرارة.
قوله تعالى: ( تُسْقى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ ) أي حارّة بالغة في حرارتها.
قوله تعالى: ( ليسَ لَهُمْ طَعامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لا يُسْمِنُ وَ لا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ) قيل: الضريع نوع من الشوك يقال له: الشبرق و أهل الحجاز يسمّونه الضريع إذا يبس و هو أخبث طعام و أبشعه لا ترعاه دابّة، و لعلّ تسمية ما في النار به لمجرّد المشابهة شكلاً و خاصّة.
قوله تعالى: ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ ) من النعومة فيكون كناية عن البهجة و السرور الظاهر على البشرة كما قال:( تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ) المطفّفين: 24، أو من النعمة أي متنعّمة. قيل: و لم يعطف على قوله:( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ ) إشارة إلى كمال البينونة بين حالي الفريقين.
قوله تعالى: ( لِسَعْيِها راضِيَةٌ ) اللّام للتقوية، و المراد بالسعي سعيها في الدنيا بالعمل الصالح، و المعنى رضيت سعيها و هو عملها الصالح حيث جوزيت به جزاءً حسناً.
قوله تعالى: ( فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ - إلى قوله -وَ زَرابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ) المراد بعلوّها ارتفاع درجاتها و شرفها و جلالتها و غزارة عيشها فإنّ فيها حياة لا موت معها، و لذّة لا ألم يشوبها و سروراً لا غمّ و لا حزن يداخله لهم فيها فوق ما يشاؤن.
و قوله:( لا تَسْمَعُ فِيها لاغِيَةً ) أي لا تسمع تلك الوجوه في الجنّة كلمة ساقطة لا فائدة فيها.
و قوله:( فِيها عَيْنٌ جارِيَةٌ ) المراد بالعين جنسها فقد عدّ تعالى فيها عيوناً في كلامه كالسلسبيل و الشراب الطهور و غيرهما.
و قوله:( فِيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ) السرر جمع سرير و في ارتفاعها جلالة القاعد عليها،( وَ أَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ ) الأكواب جمع كوب و هو الإبريق لا خرطوم له و لا عروة يتّخذ فيه الشراب( وَ نَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ ) النمارق جمع نمرقة و هي الوسادة و كونها مصفوفة وضعها في المجلس بحيث يتّصل بعضها ببعض على هيئة المجالس الفاخرة في الدنيا( وَ زَرابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ) الزرابيّ جمع زريبة مثلّثة الزاي و هي البساط الفاخر و بثّها بسطها للقعود عليها.
قوله تعالى: ( أَ فَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ) بعد ما فرغ من وصف الغاشية و بيان حال الفريقين، المؤمنين و الكفّار عقّبه بإشارة إجماليّة إلى التدبير الربوبيّ الّذي يفصح عن ربوبيّته تعالى المقتضية لوجوب عبادته و لازم ذلك حساب الأعمال و جزاء المؤمن بإيمانه و الكافر بكفره و الظرف الّذي فيه ذلك هو الغاشية.
و قد دعاهم أوّلاً أن ينظروا إلى الإبل كيف خلقت؟ و كيف صوّر الله سبحانه أرضاً عادمة للحياة فاقدة للشعور بهذه الصورة العجيبة في أعضائها و قواها و أفاعيلها فسخّرها لهم ينتفعون من ركوبها و حملها و لحمها و ضرعها و جلدها و وبرها حتّى بولها و بعرتها فهل هذا كله توافق اتّفاقيّ غير مطلوب بحياله.؟
و تخصيص الإبل بالذكر من جهة أنّ السورة مكّيّة و أوّل من تتلى عليهم الإعراب و اتّخاذ الآبال من أركان عيشتهم.
قوله تعالى: ( وَ إِلَى السَّماءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ) و زيّنت بالشمس و القمر و سائر النجوم الزواهر بما فيها من المنافع لأهل الأرض و قد جعل دونها الهواء الّذي يضطرّ إليه الحيوان في تنفّسه.
قوله تعالى: ( وَ إِلَى الْجِبالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ) و هي أوتاد الأرض المانعة من مورها و مخازن الماء الّتي تتفجّر منها العيون و الأنهار و محافظ للمعادن.
قوله تعالى: ( وَ إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ) أي بسطت و سوّيت فصلحت لسكنى الإنسان و سهل فيها النقل و الانتقال و أغلب التصرّفات الصناعيّة الّتي للإنسان.
فهذه تدبيرات كلّيّة مستندة إليه تعالى بلا ريب فيه فهو ربّ السماء و الأرض ما بينهما فهو ربّ العالم الإنسانيّ يجب عليهم أن يتّخذوه ربّاً و يوحّدوه و يعبدوه و أمامهم الغاشية و هو يوم الحساب و الجزاء.
قوله تعالى: ( فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ ) تفريع على ما تقدّم و المعنى إذا كان الله سبحانه هو ربّهم لا ربّ سواه و أمامهم يوم الحساب و الجزاء لمن آمن منهم أو كفر فذكّرهم بذلك.
و قوله:( إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ ) بيان أنّ وظيفته - و هو رسول - التذكرة رجاء أن يستجيبوا و يؤمنوا من غير إكراه و إلجاء.
قوله تعالى: ( لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ) المصيطر - و أصله المسيطر - المتسلّط، و الجملة بيان و تفسير لقوله:( إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ ) .
قوله تعالى: ( إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَ كَفَرَ ) استثناء من المفعول المحذوف لقوله السابق:( فَذَكِّرْ ) و التقدير فذكّر الناس إلّا من تولّى منهم عن التذكرة و كفر إذ تذكرته لغو لا فائدة فيها، و معلوم أنّ التولّي و الكفر إنّما يكون بعد التذكرة فالمنفيّ بالاستثناء هو التذكرة بعد التذكرة كأنّه قيل: ذكّرهم و أدم التذكرة إلّا لمن ذكّرته فتولّى عنها و كفر، فليس عليك إدامة تذكرته بل أعرض عنه فيعذّبه الله العذاب الأكبر.
فقوله:( فَذَكِّرْ - إلى أن قال -إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَ كَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللهُ الْعَذابَ الْأَكْبَرَ ) في معنى قوله:( فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى - إلى أن قال -وَ يَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرى ) الأعلى: 12 و قد تقدّم بيانه.
و قيل: الاستثناء من ضمير( عَلَيْهِمْ ) في قوله:( لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ) و المعنى لست عليهم بمتسلّط إلّا على من تولّى منهم عن التذكرة و أقام على الكفر فسيُسلّطك الله عليه و يأمرك بالجهاد فتقاتله فتقتله.
و قيل: الاستثناء منقطع و المعنى لست عليهم بمتسلّط لكنّ من تولّى و كفر منهم يعذّبه الله العذاب الأكبر، و ما قدّمناه من الوجه أرجح و أقرب.
قوله تعالى: ( فَيُعَذِّبُهُ اللهُ الْعَذابَ الْأَكْبَرَ ) هو عذاب جهنّم فالآية كما تقدّم محاذية لقوله في سورة الأعلى( الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرى ) .
قوله تعالى: ( إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ ) الإياب الرجوع و( إِلَيْنا ) خبر إنّ و إنّما قدّم للتأكيد و لرعاية الفواصل دون الحصر إذ لا قائل برجوع الناس إلى غير الله سبحانه و الآية في مقام التعليل للتعذيب المذكور في الآية السابقة.
قوله تعالى: ( ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ ) الكلام فيه كالكلام في الآية السابقة.
( بحث روائي)
في المجمع، و قال أبوعبداللهعليهالسلام : كلّ ناصب و إن تعبّد و اجتهد يصير إلى هذه الآية( عامِلَةٌ ناصِبَةٌ تَصْلى ناراً حامِيَةً ) .
أقول: و رواه في ثواب الأعمال، مسنداً و لفظه: كلّ ناصب و إن تعبّد و اجتهد يصير إلى هذه الغاية( عامِلَةٌ ناصِبَةٌ تَصْلى ناراً حامِيَةً ) .
و فيه، عن ابن عبّاس قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : الضريع شيء في النار يشبه الشوك أمرّ من الصبر و أنتن من الجيفة و أشدّ حرّاً من النار سمّاه الله الضريع.
و في تفسير القمّيّ: في قوله تعالى:( لا تَسْمَعُ فِيها لاغِيَةً ) قال: الهزل و الكذب.
و فيه،: في قوله تعالى:( لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ) قال: بحافظ و لا كاتب عليهم.
و في الدرّ المنثور، أخرج ابن أبي شيبة و أحمد و عبد بن حميد و مسلم و الترمذيّ و النسائيّ و ابن ماجة و ابن جرير و الحاكم و ابن مردويه و البيهقيّ في الأسماء و الصفات عن جابر قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : اُمرت أن اُقاتل الناس حتّى يقولوا: لا إله إلّا الله فإذا قالوها عصموا منيّ دماءهم و أموالهم إلّا بحقّها و حسابهم على الله ثمّ قرأ( فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ) .
أقول: لا دلالة في الرواية على كون الاستثناء من ضمير( عَلَيْهِمْ ) و هو ظاهر.
و فيه، و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرعليهالسلام : في قوله تعالى:( إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَ كَفَرَ ) يريد من لم يتّعظ و لم يصدّقك و جحد ربوبيّتي و كفر نعمتي( فَيُعَذِّبُهُ اللهُ الْعَذابَ الْأَكْبَرَ ) يريد الغليظ الشديد الدائم( إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ ) يريد مصيرهم( ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ ) يريد جزاءهم.
و في النهج: و سئلعليهالسلام : كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم؟ قال: كما يرزقهم على كثرتهم. قيل: فكيف يحاسبهم و لا يرونه؟ قال: كما يرزقهم و لا يرونه.
و فيه، قال الصادقعليهالسلام : كلّ اُمّة يحاسبها إمام زمانها، و يعرف الأئمّة أولياءهم و أعداءهم بسيماهم و هو قوله:( وَ عَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيماهُمْ ) الحديث.
أقول: قد تقدّم توضيح معنى الحديث في تفسير الآية من سورة الأعراف، و روي هذا المعنى في البصائر، عن الصادقعليهالسلام مسنداً و في الكافي، عن الباقر و الكاظمعليهماالسلام و في الفقيه، عن الهاديعليهالسلام في الزيارة الجامعة.
( سورة الفجر مكّيّة و هي ثلاثون آية)
( سورة الفجر الآيات 1 - 30)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْفَجْرِ ( 1 ) وَلَيَالٍ عَشْرٍ ( 2 ) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ( 3 ) وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ( 4 ) هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ( 5 ) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ( 6 ) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ( 7 ) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ( 8 ) وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ( 9 ) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ( 10 ) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ( 11 ) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ( 12 ) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ( 13 ) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ( 14 ) فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ( 15 ) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ( 16 ) كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ( 17 ) وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ( 18 ) وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ( 19 ) وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ( 20 ) كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ( 21 ) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ( 22 ) وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ ( 23 ) يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ( 24 ) فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ( 25 ) وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ( 26 ) يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ( 27 ) ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ( 28 ) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ( 29 ) وَادْخُلِي جَنَّتِي ( 30 )
( بيان)
في السورة ذمّ التعلّق بالدنيا المتعقّب للطغيان و الكفران و إيعاد أهله بأشدّ عذاب الله في الدنيا و الآخرة فتبيّن أنّ الإنسان لقصور نظره و سوء فكره يرى أنّ ما آتاه الله من نعمه من كرامته على الله و أنّ ما يتلبّس به من الفقر و العدم من هوانه فيطغى و يفسد في الأرض إذا وجد و يكفر إذا فقد و قد اشتبه عليه الأمر فما يصيبه من القدرة و الثروة و من الفقر و ضيق المعاش امتحان و ابتلاء إلهيّ ليظهر به ما ذا يقدّم من دنياه لاُخراه.
فليس الأمر على ما يتوهّمه الإنسان و يقوله بل الأمر كما سيتذكره إذا وقع الحساب و حضر العذاب أنّ ما أصابه من فقر أو غنى أو قوّة أو ضعف كان امتحاناً إلهيّاً و كان يمكنه أن يقدّم من يومه لغده فلم يفعل و آثر العقاب على الثواب فليس ينال الحياة السعيدة في الآخرة إلّا النفس المطمئنّة إلى ربّها المسلمة لأمره الّتي لا تتزلزل بعواصف الابتلاءات و لا يطغيه الوجدان و لا يكفره الفقدان.
و السورة مكّيّة بشهادة سياق آياتها.
قوله تعالى: ( وَ الْفَجْرِ وَ لَيالٍ عَشْرٍ وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ وَ اللَّيْلِ إِذا يَسْرِ هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ) الفجر الصبح و الشفع الزوج، قال الراغب: الشفع ضمّ الشيء إلى مثله و يقال للمشفوع شفع. انتهى. و سري الليل مضيّه و إدباره، و الحجر العقل فقوله:( وَ الْفَجْرِ ) إقسام بالصبح و كذا الحال فيما عطف عليه من ليال و الشفع و الوتر و اللّيل.
و لعلّ ظاهر قوله:( وَ الْفَجْرِ ) أنّ المراد به مطلق الفجر و لا يبعد أيضاً أن يراد به فجر يوم النحر و هو عاشر ذي الحجّة.
و قيل: المراد فجر ذي الحجّة، و قيل: فجر المحرّم أوّل السنة و قيل: فجر يوم الجمعة، و قيل فجر ليلة جمع، و قيل: المراد به صلاة الفجر، و قيل: النهار كلّه
و قيل: فجر العيون من الصخور و غيرها و هي وجوه رديّة.
و قوله:( وَ لَيالٍ عَشْرٍ ) لعلّ المراد بها الليالي العشر من أوّل ذي الحجّة إلى عاشرها و التنكير للتفخيم.
و قيل: المراد بها الليالي العشر من آخر شهر رمضان، و قيل: الليالي العشر من أوّله، و قيل الليالي العشر من أوّل المحرّم، و قيل: المراد عبادة ليال عشر على تقدير أن يراد بالفجر صلاة الفجر.
و قوله( وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ ) يقبل الانطباق على يوم التروية و يوم عرفة و هو الأنسب على تقدير أن يراد بالفجر و ليال عشر فجر ذي الحجّة و العشر الأوّل من لياليها.
و قيل: المراد صلاتاً الشفع و الوتر في آخر الليل، و قيل: مطلق الصلاة فمنها شفع و منها وتر، و قيل: الشفع يوم النحر و الوتر يوم عرفة، و قيل: الشفع جميع الخلق لأنّه قال:( وَ خَلَقْناكُمْ أَزْواجاً ) النبأ: 8 و الوتر هو الله تعالى، و على هذه الأقوال روايات ستوافيك في البحث الروائيّ الآتي إن شاء الله.
و قيل: المراد الزوج و الفرد من العدد، و في الإقسام بهما تذكير بالعدد لما في ضبط المقادير به من عظيم النعمة من الله سبحانه، و قيل: الشفع و الوتر جميع المخلوقات لأنّ الأشياء إمّا زوج و إمّا فرد، و قيل: الوتر آدم شفع بزوجته، و قيل: الشفع الأيّام و الليالي و الوتر اليوم الّذي لا ليل بعده و هو يوم القيامة، و قيل: الشفع الصفا و المروة و الوتر البيت الحرام، و قيل: الشفع أيّام عاد و الوتر لياليها، و قيل: الشفع أبواب الجنّة و هي ثمانية و الوتر أبواب جهنّم و هي سبعة إلى غير ذلك و هي كثيرة أنّهاها بعضهم إلى ستّة و ثلاثين قولاً و لا يخلو أكثرها من تحكّم.
و قوله:( وَ اللَّيْلِ إِذا يَسْرِ ) أي يمضي فهو كقوله:( وَ اللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ) المدّثر: 33 و ظاهره أنّ اللّام للجنس فالمراد به مطلق آخر الليل، و قيل: المراد به ليلة المزدلفة و هي ليلة النحر الّتي يسري فيها الحاجّ من عرفات إلى المزدلفة فيجتمع فيها على طاعة الله ثمّ يغدوا منها إلى منى و هو كما ترى و خاصّة على القول بكون المراد بليال
عشر هو الليالي العشر الأوائل منها.
و قوله:( هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ) الإشارة بذلك إلى ما تقدّم من القسم، و الاستفهام للتقرير، و المعنى أنّ في ذلك الّذي قدّمناه قسماً كافياً لمن له عقل يفقه به القول و يميّز الحقّ من الباطل، و إذا أقسم الله سبحانه بأمر - و لا يقسم إلّا بما له شرف و منزلة - كان من القول الحقّ المؤكّد الّذي لا ريب في صدقه.
و جواب الأقسام المذكورة محذوف يدلّ عليه ما سيذكر من عذاب أهل الطغيان و الكفران في الدنيا و الآخرة و ثواب النفوس المطمئنّة، و أنّ إنعامه تعالى على من أنعم عليه و إمساكه عنه فيمن أمسك إنّما هو ابتلاء و امتحان.
و حذف الجواب و الإشارة إليه على طريق التكنية أوقع و آكد في باب الإنذار و التبشير.
قوله تعالى: ( أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ ) هم عاد الاُولى قوم هود تكرّرت قصّتهم في القرآن الكريم و اُشير إلى أنّهم كانوا بالأحقاف، و قد قدّمنا ما يتحصّل من قصصهم في القرآن الكريم في تفسير سورة هود.
قوله تعالى: ( إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُها فِي الْبِلادِ ) العماد و جمعه عمد ما يعتمد عليه الأبنية، و ظاهر الآيتين أنّ إرم كانت مدينة لهم معمورة عديمة النظير ذات قصور عالية و عمد ممدّدة، و قد انقطعت أخبار القوم عهدهم و انمحت آثارهم، فلا سبيل إلى الحصول على تفصيل حالهم تطمئنّ إليها النفس إلّا ما قصّة القرآن الكريم من إجمال قصّتهم أنّهم كانوا بعد قوم نوح قاطنين بالأحقاف و كانوا ذوي بسطة في الخلق اُولي قوّة و بطش شديد، و كان لهم تقدّم و رقي في المدنيّة و الحضارة لهم بلاد عامرة و أراض خصبة ذات جنّات و نخيل و زروع و مقام كريم و قد تقدّمت القصّة.
و قيل: المراد بإرم قوم عاد - و هو في الأصل اسم أبيهم سمّوا باسم أبيهم كما يقال: قريش و يراد به القرشيّون و يطلق إسرائيل و يراد به بنو إسرائيل - و المراد بكونهم ذات عماد كونهم اُولي قوّة و سطوة.
و المعنى: أ لم تر كيف فعل ربّك بقوم عاد الّذين هم قوم إرم ذوو القوّة و الشدّة الّذين لم يخلق مثلهم في بسطة الجسم و القوّة و البطش في البلاد أو في أقطار الأرض و لا يخلو من بعد من ظاهر اللفظ.
و أبعد منه ما قيل: إنّ المراد بكونهم ذات العماد أنّهم كانوا أهل عمد سيّارة في الربيع فإذا هاج النبت رجعوا إلى منازلهم.
و من الأساطير قصّة جنّة إرم المشهورة المرويّة عن وهب بن منبّه و كعب الأحبار.
قوله تعالى: ( وَ ثَمُودَ الَّذِينَ جابُوا الصَّخْرَ بِالْوادِ ) الجوب القطع أي قطعوا صخر الجبال بنحتها بيوتاً فهو في معنى قوله:( وَ تَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً ) الشعراء: 149.
قوله تعالى: ( وَ فِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتادِ ) هو فرعون موسى، و سمّي ذا الأوتاد - على ما في بعض الروايات - لأنّه كان إذا أراد أن يعذّب رجلاً بسطه على الأرض و وتد يديه و رجليه بأربعة أوتاد في الأرض و ربّما بسطه على خشب و فعل به ذلك، و يؤيّده ما حكاه الله من قوله يهدّد السحرة إذ آمنوا بموسى:( وَ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ) طه: 71 فإنّهم كانوا يوتّدون يدي المصلوب و رجليه على خشبة الصليب.
قوله تعالى: ( الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسادَ ) صفة للمذكورين من عاد و ثمود و فرعون، و المعنى ظاهر.
قوله تعالى: ( فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذابٍ ) صبّ الماء معروف و صبّ سوط العذاب كناية عن التعذيب المتتابع المتواتر الشديد، و تنكير عذاب للتفخيم.
و المعنى فأنزل ربّك على كلّ من هؤلاء الطاغين المكثرين للفساد إثر طغيانهم و إكثارهم الفساد عذاباً شديداً متتابعاً متوالياً لا يوصف.
قوله تعالى: ( إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ ) المرصاد المكان الّذي يرصد منه و يرقب و كونه تعالى على المرصاد استعارة تمثيليّة شبّه فيها حفظه تعالى لأعمال عباده بمن
يقعد على المرصاد يرقب من يراد رقوبه فيأخذه حين يمرّ به و هو لا يشعر فالله سبحانه رقيب يرقب أعمال عباده حتّى إذا طغوا و أكثروا الفساد أخذهم بأشدّ العذاب.
و في الآية تعليل ما تقدّم من حديث تعذيب الطغاة المكثرين للفساد من الماضين و في قوله:( رَبَّكَ ) بإضافة الربّ إلى ضمير الخطاب تلويح إلى أنّ سنّة العذاب جارية في اُمّتهصلىاللهعليهوآلهوسلم على ما جرت عليه في الاُمم الماضين.
قوله تعالى: ( فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ) متفرّع على ما قبله، فيه تفصيل حال الإنسان إذا اُوتي من نعم الدنيا أو حرم كأنّه قيل: إنّ الإنسان تحت رقوب إلهيّ يرصده ربّه هل يصلح أو يفسد؟ و يبتليه و يمتحنه فيما آتاه من نعمة أو حرمة هذا هو الأمر في نفسه و أمّا الإنسان فإنّه إذا أنعم الله عليه بنعمة حسب أنّ ذلك إكرام إلهيّ له أن يفعل بها ما يشاء فيطغى و يكثر الفساد، و إذا أمسك و قدر عليه رزقه حسب أنّه إهانة إلهيّة فيكفر و يجزع.
فقوله:( فَأَمَّا الْإِنْسانُ ) المراد به النوع بحسب الطبع الأوّليّ فاللّام للجنس دون الاستغراق.
و قوله:( إِذا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ ) أي امتحنه و اختبره، و العامل في الظرف محذوف تقديره كائنا إذا إلخ و قيل: العامل فيه( فَيَقُولُ ) .
و قوله:( فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ ) تفسير للابتلاء، و المراد بالإكرام و التنعيم الصوريّان و إن شئت فقل: الإكرام و التنعيم حدوثاً لا بقاء أي إنّه تعالى أكرمه و آتاه النعمة ليشكره و يعبده لكنّه جعلها نقمة على نفسه تستتبع العذاب.
و قوله:( فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ) أي جعلني على كرامة منه بالنعم الّتي آتانيها و إن شئت فقل: القدرة و الجدة الموهوبتان إكرام و تنعيم حدوثاً و بقاء فلي أن أفعل ما أشاء.
و الجملة أعني قوله:( فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ) حكاية ما يراه الإنسان بحسب الطبع، و قول الإنسان:( رَبِّي أَكْرَمَنِ ) الظاهر في نسبة التدبير إلى الله سبحانه
- و لا يقول به الوثنيّة و المنكرون للصانع - مبنيّ على اعترافه بحسب الفطرة به تعالى و إن استنكف عنه لساناً، و أيضاً لرعاية المقابلة مع قوله:( إِذا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ ) .
قوله تعالى: ( وَ أَمَّا إِذا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهانَنِ ) أي و أمّا إذا ما امتحنه و اختبره فضيق عليه رزقه فيقول ربّي أذلّني و استخفّ بي.
و يظهر من مجموع الآيتين أوّلاً حيث كرّر الابتلاء و أثبته في صورتي التنعيم و الإمساك عنه أنّ إيتاء النعم و الإمساك عنه جميعاً من الابتلاء و الامتحان الإلهيّ كما قال:( وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً ) الأنبياء: 35 لا كما يراه الإنسان.
و ثانياً أنّ إيتاء النعم بما أنّه فضل و رحمة إكرام إن لم يبدّلها الإنسان نقما على نفسه.
و ثالثاً أنّ الآيتين معاً تفيدان أنّ الإنسان يرى سعادته في الحياة هي التنعّم في الدنيا بنعم الله تعالى و هو الكرامة عنده و الحرمان منه شقاء عنده و الحال أنّ الكرامة هي في التقرّب إليه تعالى بالإيمان و العمل الصالح سواء في ذلك الغنى و الفقر و أي وجدان و فقدان فإنّما ذلك بلاء و امتحان.
و لهم في معنى الآيتين وجوه اُخر تركنا التعرّض لها لقلّة الجدوى.
قوله تعالى: ( كَلَّا بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَ لا تَحَاضُّونَ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ ) ردع لقولهم: إنّ الكرامة هي في الغنى و التنعّم، و في الفقر و الفقدان هوان و مذلّة، و المعنى ليس كما تقولون و إنّما إيتاؤه تعالى النعمة و إمساكه عنه كلّ ذلك ابتلاء و امتحان يختبر به حال الإنسان من حيث عبوديّته.
و في قوله:( بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ) إلخ إضراب يؤكّد الردع بذكر بعض التنعّم الّذي لا يجامع الكرامة البتّة كعدم إكرامهم اليتيم بأكل تراثه و منعه منه و عدم التحريض على إطعام المسكين حبّاً للمال فالفطرة الإنسانيّة لا يرتاب في أن لا كرامة في غنى هذا شأنه.
و في الإضراب مضافاً إلى أصل الردع تقريع و لتشديد هذا التقريع وقع الالتفات من الغيبة إلى الخطاب.
فقوله:( بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ) عدم إكرامه حرمانه من تراث أبيه - كما كانوا يحرمون صغار الأولاد من الإرث - و تركه صفر الكفّ بلغ به الجهد ما بلغ كما تؤيّده الآية التالية( وَ تَأْكُلُونَ التُّراثَ ) إلخ.
و قوله:( وَ لا تَحَاضُّونَ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ ) أصله و لا تتحاضّون، و هو تحريض بعضهم بعضاً على التصدّق على المساكين المعدمين، و منشأه حبّ المال كما في الآية الآتية( وَ تُحِبُّونَ الْمالَ ) إلخ.
قوله تعالى: ( وَ تَأْكُلُونَ التُّراثَ أَكْلًا لَمًّا ) اللمّ أكل الإنسان نصيب نفسه و غيره و أكله ما يجده من دون أن يميّز الطيّب من الخبيث، و الآية تفسير لعدم إكرامهم اليتيم كما تقدّم.
قوله تعالى: ( وَ تُحِبُّونَ الْمالَ حُبًّا جَمًّا ) الجمّ الكثير العظيم، و الآية تفسّر عدم تحاضّهم على طعام المسكين كما تقدّم.
قوله تعالى: ( كَلَّا إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ) الدكّ هو الدقّ الشديد، و المراد بالظرف حضور يوم القيامة.
ردع ثان عمّا يقوله الإنسان في حالي الغنى و الفقر، و قوله:( إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ ) إلخ في مقام التعليل للردع، و محصّل المعنى ليس كما يقوله الإنسان فإنّه سيتذكّر إذا قامت القيامة إنّ الحياة الدنيا و ما فيها من الغنى و الفقر و أضرابهما لم تكن مقصودة بالذات بل كانت ابتلاء و امتحاناً من الله تعالى يميّز به السعيد من الشقيّ و يهيّئ الإنسان فيها ما يعيش به في الآخرة و قد التبس عليه الأمر فحسبها كرامة مقصودة بالذات فاشتغل بها و لم يقدّم لحياته الآخرة شيئاً فيتمنّى عند ذلك و يقول: يا ليتني قدّمت لحياتي و لن يصرف التمنّي عنه شيئاً من العذاب.
قوله تعالى: ( وَ جاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ) نسبة المجيء إليه تعالى من المتشابه الّذي يحكمه قوله تعالى:( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) الشورى: 11 و ما ورد في آيات القيامة من خواصّ اليوم كتقطّع الأسباب و ارتفاع الحجب عنهم و ظهور أنّ الله هو الحقّ المبين.
و إلى ذلك يرجع ما ورد في الروايات أنّ المراد بمجيئه تعالى مجيء أمره قال تعالى:( وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ) الانفطار: 19، و يؤيّد هذا الوجه بعض التأييد قوله تعالى( هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ وَ الْمَلائِكَةُ وَ قُضِيَ الْأَمْرُ ) البقرة: 210 إذا انضمّ إلى قوله:( هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ ) النحل: 33 و عليه فهناك مضاف محذوف و التقدير جاء أمر ربّك أو نسبة المجيء إليه تعالى من المجاز العقليّ.
و الكلام في نسبة المجيء إلى الملائكة و كونهم صفّا صفّا كما مرّ.
قوله تعالى: ( وَ جِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ) إلى آخر الآية لا يبعد أن يكون المراد بالمجيء بجهنّم إبرازها لهم كما في قوله تعالى:( وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرى ) النازعات: 36 و قوله:( وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغاوِينَ ) الشعراء: 91، و قوله:( لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ) ق: 22.
و قوله:( يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ ) أي يتذكّر أجلى التذكّر أنّ ما كان يؤتاه في الحياة الدنيا من خير أو شرّ كان من ابتلاء الله و امتحانه و أنّه قصر في أمره، هذا ما يفيده السياق.
و قوله:( وَ أَنَّى لَهُ الذِّكْرى ) أي و من أين له الذكرى كناية عن عدم انتفاعه بها فإنّ الذكرى إنّما تنفع فيما أمكنه أن يتدارك ما فرّط فيه بتوبة و عمل صالح و اليوم يوم الجزاء لا يوم الرجوع و العمل.
قوله تعالى: ( يَقُولُ يا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَياتِي ) أي لحياتي هذه و هي الحياة الآخرة أو المراد الحياة الحقيقيّة و هي الحياة الآخرة على ما نبّه تعالى عليه بقوله:( وَ ما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ ) العنكبوت: 64.
و المراد بالتقديم للحياة تقديم العمل الصالح للحياة الآخرة و ما في الآية تمنّ يتمنّاه الإنسان عند ما يتذكّر يوم القيامة و يشاهد أنّه لا ينفعه.
قوله تعالى: ( فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذابَهُ أَحَدٌ وَ لا يُوثِقُ وَثاقَهُ أَحَدٌ ) ضميراً عذابه
و وثاقه لله تعالى و المعنى فيومئذ لا يعذّب عذاب الله أحد من الخلق و لا يوثق وثاق الله أحد من الخلق أي إنّ عذابه و وثاقه تعالى يومئذ فوق عذاب الخلق و وثاقهم، تشديد في الوعيد.
و قرئ( لا يُعَذِّبُ ) بفتح الذال و( وَ لا يُوثِقُ ) بفتح الثاء بالبناء للمفعول و ضميراً عذابه و وثاقه على هذا للإنسان و المعنى لا يعذّب أحد يومئذ مثل عذاب الإنسان و لا يوثق أحد يومئذ مثل وثاقه.
قوله تعالى: ( يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ) الّذي يعطيه سياق المقابلة بين هذه النفس بما ذكر لها من الأوصاف و عيّن لها من حسن المنقلب و بين الإنسان المذكور قبل بما ذكر له من وصف التعلّق بالدنيا و الطغيان و الفساد و الكفران، و ما اُوعد من سوء المصير هو أنّ النفس المطمئنّة هي الّتي تسكن إلى ربّها و ترضى بما رضي به فترى نفسها عبداً لا يملك لنفسه شيئاً من خير أو شرّ أو نفع أو ضرّ و يرى الدنيا دار مجاز و ما يستقبله فيها من غنى أو فقر أو أيّ نفع و ضرّ ابتلاء و امتحاناً إلهيّاً فلا يدعوه تواتر النعم عليه إلى الطغيان و إكثار الفساد و العلوّ و الاستكبار، و لا يوقعه الفقر و الفقدان في الكفر و ترك الشكر بل هو في مستقرّ من العبوديّة لا ينحرف عن مستقيم صراطه بإفراط أو تفريط.
قوله تعالى: ( ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً ) خطاب ظرفه جميع يوم القيامة من لدن إحيائها إلى استقرارها في الجنّة بل من حين نزول الموت إلى دخول جنّة الخلد و ليس خطاباً واقعاً بعد الحساب كما ذكره بعضهم.
و توصيفها بالراضية لأنّ اطمئنانها إلى ربّها يستلزم رضاها بما قدّر و قضى تكويناً أو حكم به تشريعاً فلا تسخطها سانحة و لا تزيغها معصية، و إذا رضي العبد من ربّه رضي الربّ منه إذ لا يسخطه تعالى إلّا خروج العبد من زيّ العبوديّة فإذا لزم طريق العبوديّة استوجب ذلك رضى ربّه و لذا عقّب قوله( راضِيَةً ) بقوله:( مَرْضِيَّةً ) .
قوله تعالى: ( فَادْخُلِي فِي عِبادِي وَ ادْخُلِي جَنَّتِي ) تفريع على قوله:( ارْجِعِي
إِلى رَبِّكِ ) و فيه دلالة على أنّ صاحب النفس المطمئنّة في زمرة عباد الله حائز مقام العبوديّة.
و ذلك أنّه لمّا اطمأنّ إلى ربّه انقطع عن دعوى الاستقلال و رضي بما هو الحقّ من ربّه فرأى ذاته و صفاته و أفعاله ملكاً طلقاً لربّه فلم يرد فيما قدّر و قضى و لا فيما أمر و نهي إلّا ما أراده ربّه، و هذا ظهور العبوديّة التامّة في العبد ففي قوله:( فَادْخُلِي فِي عِبادِي ) تقرير لمقام عبوديّتها.
و في قوله:( وَ ادْخُلِي جَنَّتِي ) تعيين لمستقرّها، و في إضافة الجنّة إلى ضمير التكلّم تشريف خاصّ، و لا يوجد في كلامه تعالى إضافة الجنّة إلى نفسه تعالى و تقدّس إلّا في هذه الآية.
( بحث روائي)
في المجمع: في قوله تعالى:( وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ ) ، و قيل: الشفع الخلق لأنّه قال:( وَ خَلَقْناكُمْ أَزْواجاً ) و الوتر الله تعالى: عن عطيّة العوفيّ و أبي صالح و ابن عبّاس و مجاهد و هي رواية أبي سعيد الخدريّ عن النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم ، و قيل: الشفع و الوتر الصلاة منها شفع و منها وتر: و هي رواية عن ابن حصين عن النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم ، و قيل: الشفع يوم النحر و الوتر يوم عرفة: عن ابن عبّاس و عكرمة و الضحّاك، و هي رواية جابر عن النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم و الوجه فيه أنّ يوم النحر يشفّع بيوم نفر بعده و يتفرّد يوم عرفة بالموقف، و قيل: الشفع يوم التروية و الوتر يوم عرفة: و روي ذلك عن أبي جعفر و أبي عبداللهعليهماالسلام .
أقول: الروايات الثلاث المشار إليها مرويّة عن النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم من طرق أهل السنّة و يمكن الجمع بينها بأنّ المراد مطلق الشفع و الوتر و الروايات من قبيل الإشارة إلى بعض المصاديق.
و في تفسير القمّيّ:( وَ لَيالٍ عَشْرٍ ) قال: عشر ذي الحجّة( وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ ) قال: الشفع ركعتان و الوتر ركعة، و في حديث: الشفع الحسن و الحسين و الوتر أمير
المؤمنينعليهمالسلام ( وَ اللَّيْلِ إِذا يَسْرِ ) قال: هي ليلة جمع.
و فيه، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرعليهالسلام في قوله:( لِذِي حِجْرٍ ) يقول: لذي عقل.
و في العلل، بإسناده إلى أبان الأحمر قال: سألت أباعبداللهعليهالسلام عن قول الله عزّوجلّ:( وَ فِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتادِ ) لأيّ شيء سمّي ذا الأوتاد؟ فقال: لأنّه كان إذا عذّب رجلاً بسطه على الأرض على وجهه و مدّ يديه و رجليه فأوتدها بأربعة أوتاد في الأرض. و ربّما بسطه على خشب منبسط فوتّد رجليه و يديه بأربعة أوتاد ثمّ تركه على حاله حتّى يموت فسمّاه الله عزّوجلّ فرعون ذا الأوتاد.
و في المجمع: في قوله تعالى:( إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ ) وروي عن عليّعليهالسلام أنّه قال: إنّ معناه أنّ ربّك قادر أن يجزي أهل المعاصي جزاءهم.
أقول: بناء الرواية على أخذ الجملة استعارة تمثيليّة.
و فيه، عن الصادقعليهالسلام أنّه قال: المرصاد قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة عبد.
و عن الغوالي، عن الصادقعليهالسلام في حديث في تفسير قوله تعالى:( وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ ) إنّما ظنّ بمعنى استيقن أنّ الله تعالى لن يضيّق عليه رزقه أ لا تسمع قول الله تعالى:( وَ أَمَّا إِذا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ) أي ضيّق عليه.
و في تفسير القمّيّ، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرعليهالسلام في قوله:( كَلَّا إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ) قال: هي الزلزلة.
و في الدرّ المنثور، أخرج ابن مردويه عن عليّ بن أبي طالب قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : هل تدرون ما تفسير هذه الآية( كَلَّا إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ - إلى قوله -وَ جِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ) قال: إذا كان يوم القيامة تقاد جهنّم بسبعين ألف زمام بيد سبعين ألف ملك فتشرد شردة لو لا أنّ الله حبسها لأحرقت السماوات و الأرض.
أقول: و هو مرويّ أيضاً عن أبي سعيد و ابن مسعود و من طرق الشيعة في أمالي
الشيخ، بإسناده عن داود بن سليمان عن الرضا عن آبائه عن عليّعليهالسلام عن النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم .
و في العيون، في باب ما جاء عن الرضا من أخبار التوحيد بإسناده عن عليّ بن فضال عن أبيه قال: سألت الرضاعليهالسلام عن قول الله عزّوجلّ:( وَ جاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ) فقال: إنّ الله سبحانه لا يوصف بالمجيء و الذهاب تعالى عن الانتقال إنّما يعني بذلك و جاء أمر ربّك.
و في الكافي، بإسناده عن سدير الصيرفيّ قال: قلت لأبي عبداللهعليهالسلام : جعلت فداك يا ابن رسول الله هل يكره المؤمن على قبض روحه؟ قال: لا و الله إنّه إذا أتاه ملك الموت ليقبض روحه جزع عند ذلك فيقول ملك الموت: يا وليّ الله لا تجزع فوالّذي بعث محمّداً لأنّي أبرّ بك و أشفق عليك من والد رحيم لو حضرك، افتح عينيك فانظر.
قال: و يمثّل له رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم و أميرالمؤمنين و فاطمة و الحسن و الحسين و الأئمّة من ذرّيّتهمعليهمالسلام فيقال له: هذا رسول الله و أميرالمؤمنين و فاطمة و الحسن و الحسين و الأئمّةعليهمالسلام رفقاؤك.
قال: فيفتح عينيه فينظر فينادي روحه مناد من قبل ربّ العزّة فيقول: يا أيّتها النفس المطمئنّة إلى محمّد و أهل بيته ارجعي إلى ربّك راضية بالولاية مرضيّة بالثواب فادخلي في عبادي يعني محمّداً و أهل بيته و ادخلي جنّتي فما من شيء أحبّ إليه من استلال روحه و اللحوق بالمنادي.
أقول: و روى هذا المعنى القمّيّ في تفسيره و البرقيّ في المحاسن.
( سورة البلد مكّيّة و هي عشرون آية)
( سورة البلد الآيات 1 - 20)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ( 1 ) وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ( 2 ) وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ( 3 ) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ( 4 ) أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ( 5 ) يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ( 6 ) أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ ( 7 ) أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ ( 8 ) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ( 9 ) وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ( 10 ) فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ( 11 ) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ( 12 ) فَكُّ رَقَبَةٍ ( 13 ) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ( 14 ) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ( 15 ) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ( 16 ) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ( 17 ) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ( 18 ) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ( 19 ) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ( 20 )
( بيان)
تذكر السورة أنّ خلقة الإنسان مبنيّة على التعب و المشقّة فلا تجد شأناً من شؤن الحياة إلّا مقروناً بمرارة الكدّ و التعب من حين يلج في جثمانه الروح إلى أن يموت فلا راحة له عارية من التعب و المشقّة و لا سعادة له خالصة من الشقاء و المشأمة إلّا في الدار الآخرة عند الله.
فليتحمّل ثقل التكاليف الإلهيّة بالصبر على الطاعة و عن المعصية و ليجدّ في نشر الرحمة على المبتلين بنوائب الدهر كاليتم و الفقر و المرض و أضرابها حتّى يكون
من أصحاب الميمنة و إلّا فآخرته كاُولاه و هو من أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
و سياق آيات السورة، يشبه السياق المكّيّ فيؤيّد به كون السورة مكّيّة و قد ادّعى بعضهم عليه الإجماع، و قيل: السورة مدنيّة و السياق لا يساعد عليه، و قيل: مدنيّة إلّا أربع آيات من أوّلها و سيأتي في البحث الروائيّ التالي إن شاء الله تعالى.
قوله تعالى: ( لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ ) ذكروا أنّ المراد بهذا البلد مكّة و تؤيّده مكّيّة سياق السورة و قوله:( وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ ) خاصّة بناء على كون المراد بوالد هو إبراهيمعليهالسلام على ما سيجيء.
قوله تعالى: ( وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ ) حال من هذا البلد، و وضع الظاهر موضع الضمير في قوله:( بِهذَا الْبَلَدِ ) للدلالة على عظم شأنه و الاعتناء بأمره و هو البلد الحرام، و الحلّ مصدر كالحلول بمعنى الإقامة و الاستقرار في مكان و المصدر بمعنى الفاعل.
و المعنى اُقسم بهذا البلد و الحال أنك حالٌ به مقيم فيه و في ذلك تنبيه على تشرّف مكّة بحلولهصلىاللهعليهوآلهوسلم فيها و كونها مولده و مقامه.
و قيل: الجملة معترضة بين القسم و المقسم به و المراد بالحلّ المستحلّ الّذي لا حرمة له قال في الكشاف: و اعترض بين القسم و المقسم عليه بقوله:( وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ ) يعني و من المكابدة أنّ مثلك على عظم حرمتك يستحلّ بهذا البلد الحرام كما يستحلّ الصيد في غير الحرم - عن شرحبيل - يحرّمون أن يقتلوا بها صيداً و يعضدوا(1) بها شجرة و يستحلّون إخراجك و قتلك، و فيه تثبيت من رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم و بعث على احتمال ما كان يكابد من أهل مكّة و تعجيب من حالهم في عداوته انتهى.
ثمّ قال: أو سلّي رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم بالقسم ببلده أنّ الإنسان لا يخلو من مقاساة الشدائد و اعترض بأن وعده فتح مكّة تتميماً للتسلية و التنفيس عنه فقال:( وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ ) يعني و أنت حلّ به في المستقبل تصنع فيه ما تريد من القتل و الأسر إلى آخر ما قال، و محصّله تفسير الحلّ بمعنى المحلّ ضدّ المحرم، و المعنى و سنحلّ لك يوم فتح مكّة حيناً فنقاتل و تقتل فيه من شئت.
____________________
(1) عضد الشجرة: قطعها و نثر ورقها للإبل. و شرحبيل راوي الحديث.
قوله تعالى: ( وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ ) لزوم نوع من التناسب و الارتباط بين القسم و المقسم عليه يستدعي أن يكون المراد بوالد و ما ولد من بينه و بين البلد المقسم به نسبة ظاهرة و ينطبق على إبراهيم و ولده إسماعيلعليهماالسلام و هما السببان الأصليّان لبناء بلدة مكّة و البانيان للبيت الحرام قال تعالى:( وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْماعِيلُ ) البقرة: 127 و إبراهيمعليهالسلام هو الّذي سأل الله أن يجعل مكّة بلداً آمنا قال تعالى:( وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً ) إبراهيم: 35. و تنكير( والِدٍ ) للتعظيم و التفخيم، و التعبير بقوله( وَ ما وَلَدَ ) دون أن يقال: و من ولد، للدلالة على التعجيب من أمره مدحاً كما في قوله:( وَ اللهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ ) آل عمران: 36.
و المعنى و اُقسم بوالد عظيم الشأن هو إبراهيم و ما ولد من ولد عجيب أمره مبارك أثره و هو إسماعيل ابنه و هما البانيان لهذا البلد فمفاد الآيات الثلاث الإقسام بمكّة المشرّفة و بالنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم الّذي هو حلّ فيها و بإبراهيم و إسماعيل اللّذين بنياها.
و قيل: المراد بالوالد إبراهيم و بما ولد جميع أولاده من العرب.
و فيه أنّ من البعيد أن يقارن الله سبحانه بين النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم و إبراهيمعليهالسلام و بين أمثال أبي لهب و أبي جهل و غيرهم من أئمّة الكفر فيقسم بهم جميعاً في سياق، و قد تبرّأ إبراهيمعليهالسلام ممّن لم يتّبعه من بنيه على التوحيد إذ قال فيما حكاه الله:( وَ اجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَ مَنْ عَصانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) إبراهيم: 36.
فعلى من يفسّر ما ولد بأولاد إبراهيم أن يخصّهم بالمسلمين من ذرّيّته كما في دعاء إبراهيم و إسماعيل عند بنائهما الكعبة على ما حكاه الله:( رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَ أَرِنا مَناسِكَنا وَ تُبْ عَلَيْنا ) البقرة: 128.
و قيل: المراد بوالد و ما ولد، آدمعليهالسلام و ذرّيّته جميعاً بتقريب أنّ المقسم عليه بهذه الأقسام خلق الإنسان في كبد و قد سنّ الله في خلق هذا النوع و إبقاء وجوده سنّة الولادة فقد أقسم في هذه الآيات بمحصول هذه السنّة و هو الوالد و ما ولد على أنّ الإنسان في كدّ و تعب بحسب نوع خلقته من حين يحيى إلى حين يموت.
و هذا الوجه في نفسه لا بأس به لكن يبقى عليه بيان المناسبة بين بلدة مكّة و بين والد و كلّ مولود في الجمع بينهما في الأقسام.
و قيل: المراد بهما آدم و الصالحون من ذرّيّته، و كأنّ الوجه فيه تنزيهه تعالى من أن يقسم بأعدائه الطغاة و المفسدين من الكفّار و الفسّاق.
و قيل: المراد بهما كلّ والد و كلّ مولود و قيل: من يلد و من لا يلد منهم بأخذ( ما ) في( ما وَلَدَ ) نافية لا موصولة.
و قيل: المراد بوالد هو النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم و بما ولد اُمّته لأنّه بمنزلة الأب لاُمّته و هي وجوه بعيدة.
قوله تعالى: ( لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي كَبَدٍ ) الكبد الكدّ و التعب، و الجملة جواب القسم فاشتمال الكبد على خلق الإنسان و إحاطة الكدّ و التعب به في جميع شؤن حياته ممّا لا يخفى على ذي لبّ فليس يقصد نعمة من نعم الدنيا إلّا خالصة في طيبها محضة في هنائها و لا ينال شيئاً منها إلّا مشوبة بما ينغّص العيش مقرونة بمقاساة و مكابدة مضافاً إلى ما يصيبه من نوائب الدهر و يفاجئه من طوارق الحدثان.
قوله تعالى: ( أَ يَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ) بمنزلة النتيجة لحجّة الآية السابقة تقريرها أنّ الإنسان لمّا كانت خلقته مبنيّة على كبد مظروفة له لا ينال قطّ شيئاً ممّا يريد إلّا دون ما يريد أو غير ما يريد فهو محاط في خلقه مغلوب في إرادته مقهور فيما قدّر له من الأمر و الّذي يغلبه في إرادته و يقهره على التلبّس بما قدّر له و هو الله سبحانه يقدر عليه من كلّ جهة فله أن يتصرّف فيه بما شاء و يأخذه إذا أراد.
فليس للإنسان أن يحسب أن لن يقدر عليه أحد فيدعوه ذلك إلى أن يعلو على الله و يستكبر عن عبادته أو يعطيه في بعض ما أمر به كالإنفاق في سبيله فيستكثره و يمتنّ به على الله أو يمكر به تعالى بعد ما عمله رياء و سمعة عملاً لوجه الكريم فيقول: أهلكت مالاً لبدا.
قوله تعالى: ( يَقُولُ أَهْلَكْتُ مالًا لُبَداً ) اللبد الكثير، سياق الآية و ما يتلوها من الآيات إلى آخر السورة مشعر بأنه كان هناك بعض من أظهر الإسلام أو مال إليه
قد أنفق بعض ماله و امتنّ به مستكثراً له بقوله:( أَهْلَكْتُ مالًا لُبَداً ) فنزلت الآيات و ردّ الله عليه بأنّ الفوز بميمنة الحياة لا يتمّ إلّا باقتحام عقبة الإنفاق في سبيل الله و الدخول في زمرة الّذين آمنوا و تواصوا بالصبر و المرحمة، و يتأيّد به ما سيأتي في البحث الروائيّ إن شاء الله تعالى.
قوله تعالى: ( أَ يَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ) إنكار لما هو لازم قول الإنسان:( أَهْلَكْتُ مالًا لُبَداً ) على طريق التكنية و محصّل المعنى أنّ لازم إخبار الإنسان بإهلاكه مالاً لبداً أنّه يحسب أنّا في غفلة و جهل بما أنفق و قد أخطأ في ذلك فالله سبحانه بصير بما أنفق لكنّ هذا المقدار لا يكفي في الفوز بميمنة الحياة بل لا بدّ له من أن يتحمّل ما هو أزيد من ذلك من مشاقّ العبوديّة فيقتحم العقبة و يكون مع المؤمنين في جميع ما هم فيه.
قوله تعالى: ( أَ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَ لِساناً وَ شَفَتَيْنِ وَ هَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ ) النجد الطريق المرتفع، و المراد بالنجدين طريق الخير و طريق الشرّ و سمّيا النجدين لما في سلوك كلّ منهما من الجهد و الكدح، و فسّراً بثديي الاُم و هو بعيد.
و قوله:( أَ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ) أي جهّزناه في بدنه بما يبصر به فيحصل له العلم بالمرئيّات على سعة نطاقها، و قوله:( وَ لِساناً وَ شَفَتَيْنِ ) أي أ و لم نجعل له لساناً و شفتين يستعين بها على التكلّم و الدلالة على ما في ضميره من العلم و يهتدي بذلك غيره على العلم بالاُمور الغائبة عن البصر.
و قوله:( وَ هَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ ) أي علّمناه طريق الخير و طريق الشرّ بإلهام منّا فهو يعرف الخير و يميّزه من الشرّ فالآية في معنى قوله تعالى:( وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها ) الشمس: 8.
و في الآيات الثلاث حجّة على قوله:( أَ يَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ) أي على أنّه تعالى يرى أعمال عباده و يعلم ما في ضمائرهم من وجوه الأعمال و يميّز الخير من الشرّ و الحسنة من السيّئة.
محصّلها أنّ الله سبحانه هو الّذي يعرّف المرئيّات للإنسان بوسيلة عينيه و كيف يتصوّر أن يعرّفه أمراً و هو لا يعرفه؟ و هو الّذي يدلّ الإنسان على ما في الضمير بواسطة الكلام و هل يعقل أن يكشف له عمّا هو في حجاب عنه؟ و هو الّذي يعلّم الإنسان و يميّز له الخير و الشرّ بالإلهام و هل يمكن معه أن يكون هو نفسه لا يعلم به و لا يميّزه؟ فهو تعالى يرى ما عمله الإنسان و يعلم ما ينويه بعمله و يميّز كونه خيراً أو شرّاً و حسنة أو سيّئة.
قوله تعالى: ( فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ) الاقتحام الدخول بسرعة و ضغط و شدّة، و العقبة الطريق الصعب الوعر الّذي فيه صعود من الجبل، و اقتحام العقبة إشارة إلى الإنفاق الّذي يشقّ على منفقه كما سيصرّح به.
و قيل: الجملة دعاء على الإنسان القائل: أهلكت مالاً لبداً، و ليس بشيء.
قوله تعالى: ( وَ ما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ ) تفخيم لشأنها كما مرّ في نظائره.
قوله تعالى: ( فَكُّ رَقَبَةٍ ) أي عتقها و تحريرها أو التقدير هي أي العقبة فكّ رقبة فالمراد بالعقبة نفس الفكّ الّذي هو العمل و اقتحامه الإتيان به، و الإتيان بالعمل نفس العمل.
و به يظهر فساد قول بعضهم إنّ فكّ رقبة اقتحام للعقبة لا نفس العقبة فهناك مضاف محذوف يعود إليه الضمير و التقدير و ما أدراك ما اقتحام العقبة هو - أي الاقتحام - فكّ رقبة.
و ما ذكر في بيان العقبة من فكّ الرقبة و الإطعام في يوم ذي مسغبة من مصاديق نشر الرحمة خصّ بالذكر لمكان الأهمّيّة، و قدّم فكّ الرقبة و ابتدئ به لكمال عناية الدين بفكّ الرقاب.
قوله تعالى: ( أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ ) المسغبة المجاعة، و المقربة القرابة بالنسب، و المتربة من التراب و معناها الالتصاق بالتراب من شدّة الفقر، و المعنى أو إطعام في يوم المجاعة يتيماً من ذي القربى أو
مسكيناً شديد الفقر.
قوله تعالى: ( ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ وَ تَواصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ) المرحمة مصدر ميميّ من الرحمة، و التواصي بالصبر وصيّة بعضهم بعضاً بالصبر على طاعة الله و التواصي بالمرحمة وصيّة بعضهم بعضاً بالرحمة على ذوي الفقر و الفاقة و المسكنة.
و الجملة أعني قوله:( ثُمَّ كانَ ) إلخ معطوفة على قول:( اقْتَحَمَ ) و التقدير فلا اقتحم العقبة و لا كان من الّذين آمنوا إلخ و قيل فيها غير ذلك ممّا لا جدوى فيه.
قوله تعالى: ( أُولئِكَ أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ ) بمعنى اليمن مقابل الشؤم، و الإشارة باُولئك إلى ما يدلّ عليه السياق السابق أي الّذين اقتحموا العقبة و كانوا من الّذين آمنوا و تواصوا بالصبر و المرحمة أصحاب اليمن لا يرون ممّا قدّموه من الإيمان و عملهم الصالح إلّا أمراً مباركاً جميلاً مرضيّاً.
و قيل: المراد بالميمنة جهة اليمين و أصحاب الميمنة هم الّذين يؤتون كتابهم بيمينهم، و مقابلة الميمنة بالمشأمة لا تلائمه.
قوله تعالى: ( وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا هُمْ أَصْحابُ الْمَشْأَمَةِ ) الآيات الآفاقيّة و الأنفسية آيات و أدلّة عليه تعالى تدلّ على توحّده في الربوبيّة و الاُلوهيّة و سائر ما يتفرّع عليه و ردّها كفر بها و الكفر بها كفر بالله و كذا القرآن الكريم و آياته، و كذا ما نزل و بلّغ من طريق الرسالة.
و الظاهر أنّ المراد بالآيات مطلقها، و المشأمة خلاف الميمنة.
قوله تعالى: ( عَلَيْهِمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ ) أي مطبقة.
( بحث روائي)
في المجمع: في قوله:( وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ ) قيل: معناه و أنت محلّ بهذا البلد و هو ضدّ المحرم، و المراد أنت حلال لك قتل من رأيت من الكفّار، و ذلك حين اُمر بالقتال يوم فتح مكّة فأحلّها الله له حتّى قاتل و قتل، و قد قالصلىاللهعليهوآلهوسلم : لم يحلّ لأحد قبلي و لا يحلّ لأحد بعدي و لم يحلّ لي إلّا ساعة من نهار. عن ابن عبّاس
و مجاهد و عطاء.
و فيه: في الآية و قيل: لا اُقسم بهذا البلد و أنت حلال منتهك الحرمة مستباح العرض لا تحترم فلا تبقى للبلد حرمة حيث هتكت: عن أبي مسلم و هو المرويّ عن أبي عبداللهعليهالسلام .
قال: كانت قريش تعظّم البلد و تستحلّ محمّداً فيه فقال:( لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ ) يريد أنّهم استحلّوك فيه و كذّبوه و شتموك، و كانوا لا يأخذ الرجل منهم فيه قاتل أبيه و يتقلّدون لحاء شجر الحرم فيأمنون بتقلّدهم إيّاه فاستحلّوا من رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ما لم يستحلّوه من غيره فعاب الله ذلك عليهم.
و فيه: في قوله تعالى:( وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ ) قيل: آدم و ما ولد من الأنبياء و الأوصياء و أتباعهم. عن أبي عبداللهعليهالسلام .
أقول: و المعاني السابقة مرويّة من طرق أهل السنّة في أحاديث موقوفة، و روى القمّيّ في تفسيره الأخيرتين بالإرسال و الإضمار.
و في تفسير القمّيّ:( يَقُولُ أَهْلَكْتُ مالًا لُبَداً ) قال: اللبد المجتمع و في المجمع: في الآية قيل: هو الحارث بن نوفل بن عبد مناف و ذلك أنّه أذنب ذنبا فاستفتى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فأمره أن يكفّر فقال: لقد ذهب مالي في الكفّارات و النفقات منذ دخلت في دين محمّد، عن مقاتل.
و في المجمع: أنّه قيل لأميرالمؤمنينعليهالسلام : إنّ اُناسا يقولون في قوله:( وَ هَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ ) أنّهما الثديان فقال: لا، هما الخير و الشرّ.
و في اُصول الكافي، بإسناده عن حمزة بن محمّد عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: سألته عن قول الله تعالى:( وَ هَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ ) قال: نجد الخير و الشرّ.
أقول: و روي في الدرّ المنثور، هذا المعنى بطرق عن عليّعليهالسلام و أنس و أبي أمامة و غيرهم عن النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم و رواه القمّيّ في تفسيره، مرسلاً مضمراً.
و في الكافي، بإسناده عن جعفر بن خلّاد قال: كان أبوالحسن الرضاعليهالسلام إذا أكل اُتي بصحفة فتوضع قرب مائدته فيعمد إلى أطيب الطعام ممّا يؤتى به فيأخذ من كلّ
شيء شيئاً فيضع في تلك الصحفة ثمّ يأمر بها للمساكين ثمّ يتلو هذه الآية( فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ) .
ثمّ يقول: علم الله عزّوجلّ أنّه ليس كلّ إنسان يقدر على عتق رقبة فجعل لهم السبيل إلى الجنّة.
و في المجمع، و روي مرفوعاً عن البراء بن عازب قال: جاء أعرابيّ إلى النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم فقال: يا رسول الله علّمني عملاً يدخلني الجنّة قال: إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة و فكّ الرقبة، فقال أ و ليسا واحداً؟ قال: لا، عتق الرقبة أن يتفرّد بعتقها و فكّ الرقبة أن يعين في ثمنها، و الفيء على ذي الرحم الظالم.
فإن لم يكن ذلك فأطعم الجائع و اسق الظمآن و أمر بالمعروف و أنه عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكفّ لسانك إلّا من خير.
و في تفسير القمّيّ: في قوله تعالى:( أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ ) قال: لا يقيه من التراب شيء.
( سورة الشمس مكّيّة و هي خمس عشرة آية)
( سورة الشمس الآيات 1 - 15)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ( 1 ) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا ( 2 ) وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا ( 3 ) وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ( 4 ) وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ( 5 ) وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ( 6 ) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ( 7 ) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ( 8 ) قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ( 9 ) وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ( 10 ) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ( 11 ) إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ( 12 ) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُقْيَاهَا ( 13 ) فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا ( 14 ) وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ( 15 )
( بيان)
تذكر السورة أنّ فلاح الإنسان - و هو يعرف التقوى و الفجور بتعريف إلهيّ و إلهام باطنيّ - أن يزكّي نفسه و ينميها إنماءً صالحاً بتحليتها بالتقوى و تطهيرها من الفجور، و الخيبة و الحرمان من السعادة لمن يدسّيها، و يستشهد لذلك بما جرى على ثمود من عذاب الاستئصال لمّا كذّبوا رسولهم صالحاً و عقروا الناقة، و في ذلك تعريض لأهل مكّة، و السورة مكّيّة بشهادة من سياقها.
قوله تعالى: ( وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها ) في المفردات: الضحى انبساط الشمس و امتداد النهار و سمّي الوقت به انتهى. و الضمير للشمس، و في الآية إقسام بالشمس و انبساط ضوئها على الأرض.
قوله تعالى: ( وَ الْقَمَرِ إِذا تَلاها ) عطف على الشمس و الضمير لها و إقسام بالقمر
حال كونه تاليا للشمس، و المراد بتلوّه لها إن كان كسبه النور منها فالحال حال دائمة و إن كان طلوعه بعد غروبها فالإقسام به من حال كونه هلالاً إلى حال تبدّره.
قوله تعالى: ( وَ النَّهارِ إِذا جَلَّاها ) التجلية الإظهار و الإبراز، و ضمير التأنيث للأرض، و المعنى و اُقسم بالنهار إذا أظهر الأرض للأبصار.
و قيل: ضمير الفاعل في( جَلَّاها ) للنهار و ضمير المفعول للشمس، و المراد الإقسام بحال إظهار النهار للشمس فإنّها تنجلي و تظهر إذا انبسط النهار، و فيه أنّه لا يلائم ما تقدّمه فإنّ الشمس هي المظهرة للنهار دون العكس.
و قيل: الضمير المؤنّث للدنيا، و قيل: للظلمة، و قيل: ضمير الفاعل لله تعالى و ضمير المفعول للشمس، و المعنى و اُقسم بالنهار إذا أظهر الله الشمس، و هي وجوه بعيدة.
قوله تعالى: ( وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشاها ) أي يغطي الأرض، فالضمير للأرض كما في( جَلَّاها ) و قيل: للشمس و هو بعيد فالليل لا يغطّي الشمس و إنّما يغطّي الأرض و ما عليها.
و التعبير عن غشيان الليل الأرض بالمضارع بخلاف تجلية النهار لها حيث قيل:( وَ النَّهارِ إِذا جَلَّاها وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشاها ) للدلالة على الحال ليكون فيه إيماء إلى غشيان الفجور الأرض في الزمن الحاضر الّذي هو أوائل ظهور الدعوة الإسلاميّة لما تقدّم أنّ بين هذه الأقسام و بين المقسم بها نوع اتّصال و ارتباط، هذا مضافاً إلى رعاية الفواصل.
قوله تعالى: ( وَ السَّماءِ وَ ما بَناها وَ الْأَرْضِ وَ ما طَحاها ) طحو الأرض و دحوها بسطها، و( ما ) في( وَ ما بَناها ) و( ما طَحاها ) موصولة، و الّذي بناها و طحاها هو الله تعالى و التعبير عنه تعالى بما دون من لإيثار الإبهام المفيد للتفخيم و التعجيب فالمعنى و اُقسم بالسماء و الشيء القوي العجيب الّذي بناها و اُقسم بالأرض و الشيء القويّ العجيب الّذي بسطها.
و قيل: ما مصدريّة و المعنى و اُقسم بالسماء و بنائها و الأرض و طحوها، و السياق
- و فيه قوله:( وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها ) إلخ - لا يساعده.
قوله تعالى: ( وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها ) أي و اُقسم بنفس و الشيء ذي القدرة و العلم و الحكمة الّذي سوّاها و رتّب خلقتها و نظم أعضاءها و عدّل بين قواها.
و تنكير( نَفْسٍ ) قيل: للتنكير، و قيل: للتفخيم و لا يبعد أن يكون التنكير للإشارة إلى أنّ لها وصفاً و أنّ لها نبأ.
و المراد بالنفس النفس الإنسانيّة مطلقاً و قيل: المراد بها نفس آدمعليهالسلام و لا يلائمه السياق و خاصّة قوله:( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها ) إلّا بالاستخدام على أنّه لا موجب للتخصيص.
قوله تعالى: ( فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها ) الفجور - على ما ذكره الراغب - شقّ ستر الديانة فالنهي الإلهيّ عن فعل أو عن ترك حجاب مضروب دونه حائل بين الإنسان و بينه و اقتراف المنهيّ عنه شقّ للستر و خرق للحجاب.
و التقوى - على ما ذكره الراغب - جعل النفس في وقاية ممّا يخاف، و المراد بها بقرينة المقابلة في الآية بينها و بين الفجور التجنّب عن الفجور و التحرّز عن المنافي و قد فسّرت في الرواية بأنّها الورع عن محارم الله.
و الإلهام الإلقاء في الروع و هو إفاضته تعالى الصور العمليّة من تصوّر أو تصديق على النفس.
و تعليق الإلهام على عنواني فجور النفس و تقواها للدلالة على أنّ المراد تعريفه تعالى للإنسان صفة فعله من تقوى أو فجور وراء تعريفه متن الفعل بعنوانه الأوّليّ المشترك بين التقوى و الفجور كأكل المال مثلاً المشترك بين أكل مال اليتيم الّذي هو فجور و بين أكل مال نفسه الّذي هو من التقوى، و المباشرة المشتركة بين الزنا و هو فجور و النكاح و هو من التقوى و بالجملة المراد أنّه تعالى عرّف الإنسان كون ما يأتي به من فعل فجوراً أو تقوى و ميّز له ما هو تقوى ممّا هو فجور.
و تفريع الإلهام على التسوية في قوله:( وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها ) إلخ للإشارة إلى أنّ إلهام الفجور و التقوى و هو العقل العملي من تكميل تسوية النفس فهو من نعوت
خلقتها كما قال تعالى:( فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ) الروم: 30.
و إضافة الفجور و التقوى إلى ضمير النفس للإشارة إلى أنّ المراد بالفجور و التقوى الملهمين الفجور و التقوى المختصّين بهذه النفس المذكورة و هي النفس الإنسانيّة و نفوس الجنّ على ما يظهر من الكتاب العزيز من كونهم مكلّفين بالإيمان و العمل الصالح.
قوله تعالى: ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها ) الفلاح هو الظفر بالمطلوب و إدراك البغية، و الخيبة خلافه، و الزكاة نموّ النبات نموّاً صالحاً ذا بركة و التزكية إنماؤه كذلك، و التدسّي - و هو من الدسّ بقلب إحدى السينين ياء - إدخال الشيء في الشيء بضرب من الإخفاء، و المراد بها بقرينة مقابله التزكية: الإنماء على غير ما يقتضيه طبعها و ركّبت عليه نفسها.
و الآية أعني قوله:( قَدْ أَفْلَحَ ) إلخ جواب القسم، و قوله:( وَ قَدْ خابَ ) إلخ معطوف عليه.
و التعبير بالتزكية و التدسّي عن إصلاح النفس و إفسادها مبتن على ما يدلّ عليه قوله:( فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها ) على أنّ من كمال النفس الإنسانيّة أنّها ملهمة مميّزة - بحسب فطرتها - للفجور من التقوى أي أنّ الدين و هو الإسلام لله فيما يريده فطريّ للنفس فتحلية النفس بالتقوى تزكية و إنماء صالح و تزويد لها بما يمدّها في بقائها قال تعالى:( وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى وَ اتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ ) البقرة: 197 و أمرها في الفجور على خلاف التقوى.
قوله تعالى: ( كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْواها ) الطغوى مصدر كالطغيان، و الباء للسببيّة.
و الآية و ما يتلوها إلى آخر السورة استشهاد و تقرير لما تقدّم من قوله( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها ) إلخ.
قوله تعالى: ( إِذِ انْبَعَثَ أَشْقاها ) ظرف لقوله:( كَذَّبَتْ ) أو لقوله:( بِطَغْواها )
و المراد بأشقى ثمود هو الّذي عقر الناقة و اسمه على ما في الروايات قدار بن سالف و قد كان انبعاثه ببعث القوم كما تدلّ عليه الآيات التالية بما فيها من ضمائر الجمع.
قوله تعالى: ( فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ناقَةَ اللهِ وَ سُقْياها ) المراد برسول الله صالحعليهالسلام نبيّ ثمود، و قوله:( ناقَةَ اللهِ ) منصوب على التحذير، و قوله:( وَ سُقْياها ) معطوف عليه.
و المعنى فقال لهم صالح برسالة من الله: احذروا ناقة الله و سقياها و لا تتعرّضوا لها بقتلها أو منعها عن نوبتها في شرب الماء، و قد فصّل الله القصّة في سورة هود و غيرها.
قوله تعالى: ( فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوها فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاها ) العقر إصابة أصل الشيء و يطلق على نحر البعير و القتل، و الدمدمة على الشيء الإطباق عليه يقال: دمدم عليه القبر أي أطبقه عليه و المراد شمولهم بعذاب يقطع دابرهم و يمحو أثرهم بسبب ذنبهم.
و قوله:( فَسَوَّاها ) الظاهر أنّ الضمير لثمود باعتبار أنّهم قبيلة أي فسوّاها بالأرض أو هو تسوية الأرض بمعنى تسطيحها و إعفاء ما فيها من ارتفاع و انخفاض.
و قيل: الضمير للدمدمة المفهومة من قوله:( فَدَمْدَمَ ) و المعنى فسوّى الدمدمة بينهم فلم يفلت منهم قويّ و لا ضعيف و لا كبير و لا صغير.
قوله تعالى: ( وَ لا يَخافُ عُقْباها ) الضمير للدمدمة أو التسوية، و الواو للاستئناف أو الحال.
و المعنى: و لا يخاف ربّهم عاقبة الدمدمة عليهم و تسويتهم كما يخاف الملوك و الأقوياء عاقبة عقاب أعدائهم و تبعته، لأنّ عواقب الاُمور هي ما يريده و على وفق ما يأذن فيه فالآية قريبة المعنى من قوله تعالى:( لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ ) الأنبياء: 23.
و قيل: ضمير( لا يَخافُ ) للأشقى، و المعنى و لا يخاف عاقر الناقة عقبى ما صنع بها.
و قيل: ضمير( لا يَخافُ ) لصالح و ضمير( عُقْباها ) للدمدمة و المعنى و لا يخاف صالح عقبى الدمدمة عليهم لثقته بالنجاة و ضعف الوجهين ظاهر.
( بحث روائي)
في تفسير القمّيّ: في قوله تعالى:( وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها ) قال: خلقها و صورها.
و في المجمع، و روى زرارة و حمران و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبداللهعليهماالسلام في قوله تعالى:( فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها ) قال: بيّن لها ما يأتي و ما يترك، و في قوله تعالى:( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها ) قال: قد أفلح من أطاع( وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها ) قال: قد خاب من عصى.
و في الدرّ المنثور، أخرج أحمد و مسلم و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عن عمران بن حصين أنّ رجلاً قال: يا رسول الله أ رأيت ما يعمل الناس اليوم و يكدحون فيه شيء قد قضي عليهم و مضى عليهم في قدر قد سبق؟ أو فيما يستقبلون به نبيّهم و اتّخذت عليهم به الحجّة؟ قال: بل شيء قضي عليهم.
قال: فلم يعملون إذا؟ قال: من كان الله خلقه لواحدة من المنزلتين هيّأه لعملها و تصديق ذلك في كتاب الله:( وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها ) .
أقول: قوله: أو فيما يستقبلون إلخ الظاهر أنّ الهمزة فيه للاستفهام و الواو للعطف و المعنى و هل في طاعتهم لنبيّهم قضاء من الله و قدر قد سبق؟ و قوله: فلم يعملون إذا، أي فما معنى عملهم و استناد الفعل إليهم.؟
و قولهصلىاللهعليهوآلهوسلم : من كان الله إلخ معناه أنّ وجوب صدور الفعل حسنة أو سيّئة منهم بالنظر إلى القضاء و القدر السابقين لا ينافي إمكان صدوره بالنظر إلى الإنسان و اختياره، و قد اتّضح ذلك في الأبحاث السابقة من الكتاب مراراً.
و فيه، أخرج ابن أبي حاتم و أبوالشيخ و ابن مردويه و الديلميّ عن جويبر عن الضحّاك عن ابن عبّاس: سمعت رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم يقول:( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها ) الآية أفلحت نفس زكّاها الله و خابت نفس خيبّها الله من كلّ خير.
أقول: انتساب التزكية و التخييب إليه تعالى بوجه لا ينافي انتسابهما بالطاعة و المعصية إلى الإنسان.
و إنّما ينتسب إلى الله سبحانه من الإضلال ما كان على طريق المجازاة كما قال:( وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ ) البقرة: 26.
و في المجمع، و قد صحّت الرواية بالإسناد عن عثمان بن صهيب عن أبيه قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم لعليّ بن أبي طالب: من أشقى الأوّلين؟ قال: عاقر الناقة. قال: صدقت فمن أشقى الآخرين؟ قال: قلت: لا أعلم يا رسول الله. قال: الّذي يضربك على هذه فأشار إلى يافوخة.
أقول: و روي فيه هذا المعنى أيضاً عن عمّار بن ياسر.
و في تفسير البرهان: و روى الثعلبيّ و الواحديّ بإسنادهما عن عمّار و عن عثمان بن صهيب و عن الضحّاك و روى ابن مردويه بإسناده عن جابر بن سمرة و عن عمّار و عن ابن عديّ أو عن الضحّاك و روى الخطيب في التاريخ، عن جابر بن سمرة و روى الطبريّ و الموصلي و روى أحمد عن الضحّاك عن عمّار أنّه قال: قال النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم : يا عليّ أشقى الأوّلين عاقر الناقة و أشقى الآخرين قاتلك، و في رواية من يخضب هذه من هذا.
( سورة الليل مكّيّة و هي إحدى و عشرون آية)
( سورة الليل الآيات 1 - 21)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ( 1 ) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ( 2 ) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ( 3 ) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ( 4 ) فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ( 5 ) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ( 6 ) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ( 7 ) وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ( 8 ) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ( 9 ) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ( 10 ) وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ( 11 ) إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ( 12 ) وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ( 13 ) فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ( 14 ) لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ( 15 ) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ( 16 ) وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ( 17 ) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ( 18 ) وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ ( 19 ) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ( 20 ) وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ( 21 )
( بيان)
غرض السورة الإنذار و تسلك إليه بالإشارة إلى اختلاف مساعي الناس و أنّ منهم من أنفق و اتّقى و صدّق بالحسنى فسيمكّنه الله من حياة خالدة سعيدة و منهم من بخل و استغنى و كذّب بالحسنى فسيسلك الله به إلى شقاء العاقبة، و في السورة اهتمام و عناية خاصّة بأمر الإنفاق المالي.
و السورة تحتمل المكّيّة و المدنيّة بحسب سياقها.
قوله تعالى: ( وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى ) إقسام بالليل إذا يغشى النهار على حدّ قوله تعالى:( يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ ) الأعراف: 54، و يحتمل أن يكون المراد غشيانه الأرض أو الشمس.
قوله تعالى: ( وَ النَّهارِ إِذا تَجَلَّى ) عطف على الليل، و التجلّي ظهور الشيء بعد خفائه، و التعبير عن صفة الليل بالمضارع و عن صفة النهار بالماضي حيث قيل:( يَغْشى ) و( تَجَلَّى ) تقدّم فيه وجه في تفسير أوّل السورة السابقة.
قوله تعالى: ( وَ ما خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى ) عطف على الليل كسابقه، و( ما ) موصولة و المراد به الله سبحانه و إنّما عبّر بما، دون من، إيثاراً للإبهام المشعر بالتعظيم و التفخيم و المعنى و اُقسم بالشيء العجيب الّذي أوجد الذكر و الاُنثى المختلفين على كونهما من نوع واحد.
و قيل: ما مصدريّة و المعنى و اُقسم بخلق الذكر و الاُنثى و هو ضعيف.
و المراد بالذكر و الاُنثى مطلق الذكر و الاُنثى أينما تحقّقاً، و قيل: الذكر و الاُنثى من الإنسان، و قيل: المراد بهما آدم و زوجته حوّاء، و أوجه الوجوه أوّلها.
قوله تعالى: ( إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ) السعي هو المشي السريع، و المراد به العمل من حيث يهتمّ به، و هو في معنى الجمع، و شتّى جمع شتيت بمعنى المتفرّق كمرضى جمع مريض.
و الجملة جواب القسم و المعنى اُقسم بهذه المتفرّقات خلقاً و أثراً إنّ مساعيكم لمتفرّقات في نفسها و آثارها فمنها إعطاء و تقوى و تصديق و لها أثر خاصّ بها، و منها بخل و استغناء و تكذيب و لها أثر خاصّ بها.
قوله تعالى: ( فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَ اتَّقى وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى ) تفصيل تفرّق مساعيهم و اختلاف آثارها.
و المراد بالإعطاء إنفاق المال لوجه الله بقرينة مقابلته للبخل الظاهر في الإمساك عن إنفاق المال و قوله بعد:( وَ ما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّى ) .
و قوله:( وَ اتَّقى) كالمفسّر للإعطاء يفيد أنّ المراد هو الإعطاء على سبيل التقوى الدينيّة.
و قوله:( وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى ) الحسنى صفة قائمة مقام الموصوف و الظاهر أنّ التقدير بالعدة الحسنى و هي ما وعد الله من الثواب على الإنفاق لوجهه الكريم و هو تصديق البعث و الإيمان به و لازمه الإيمان بوحدانيّته تعالى في الربوبيّة و الاُلوهيّة، و كذا الإيمان بالرسالة فإنّها طريق بلوغ وعده تعالى للثواب.
و محصّل الآيتين أن يكون مؤمناً بالله و رسوله و اليوم الآخر و ينفق المال لوجه الله و ابتغاء ثوابه الّذي وعده بلسان رسوله.
و قوله:( فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى ) التيسير التهيئة و الإعداد و اليسرى الخصلة الّتي فيها يسر من غير عسر، و توصيفها باليسر بنوع من التجوّز فالمراد من تيسيره لليسرى توفيقه للأعمال الصالحة بتسهيلها عليه من غير تعسير أو جعله مستعدّاً للحياة السعيدة عند ربّه و دخول الجنّة بسبب الأعمال الصالحة الّتي يأتي بها، و الوجه الثاني أقرب و أوضح انطباقاً على ما هو المعهود من مواعد القرآن.
قوله تعالى: ( وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنى وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى وَ ما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّى ) البخل مقابل الإعطاء، و الاستغناء طلب الغنى و الثروة بالإمساك و الجمع، و المراد بالتكذيب بالحسنى الكفر بالعدّة الحسنى و ثواب الله الّذي بلّغه الأنبياء و الرسل و يرجع إلى إنكار البعث.
و المراد بتيسيره للعسرى خذلانه بعدم توفيقه للأعمال الصالحة، بتثقيلها عليه و عدم شرح صدره للإيمان أو إعداده للعذاب.
و قوله:( وَ ما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّى ) التردّي هو السقوط من مكان عال و يطلق على الهلاك فالمراد سقوطه في حفرة القبر أو في جهنّم أو هلاكه.
و( ما ) استفهاميّة أو نافية أي أيّ شيء يغنيه ماله إذا مات و هلك أو ليس يغني عنه ماله إذا مات و هلك.
قوله تعالى: ( إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى وَ إِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَ الْأُولى ) تعليل لما تقدّم من حديث تيسيره لليسرى و للعسرى أو الإخبار به بأوجز بيان، محصّله أنّا إنّما نفعل هذا التيسير أو نبيّن هذا البيان لأنّه من الهدى و الهدى علينا لا يزاحمنا في ذلك شيء و لا يمنعنا عنه مانع.
فقوله:( إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى ) يفيد أنّ هدى الناس ممّا قضى سبحانه به و أوجبه على نفسه بمقتضى الحكمة و ذلك أنّه خلقهم ليعبدوه كما قال:( وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ) الذاريات: 56 فجعل عبادته غاية لخلقهم و جعلها صراطاً مستقيماً إليه كما قال:( إِنَّ اللهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ ) آل عمران: 51، و قال:( وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ صِراطِ اللهِ ) الشورى: 53 و قضى على نفسه أن يبيّن لهم سبيله و يهديهم إليه بمعنى إراءة الطريق سواء سلكوها أم تركوها كما قال:( وَ عَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَ مِنْها جائِرٌ ) النحل: 9، و قال:( وَ اللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ) الأحزاب: 4 و قال:( إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً ) الإنسان: 3 و لا ينافي ذلك قيام غيره تعالى بأمر هذا المعنى من الهدى بإذنه كالأنبياء كما قال تعالى:( وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ) الشورى: 52، و قال:( قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي ) يوسف: 108.
و قد تقدّم لهذه المسألة بيان عقلي في مباحث النبوّة في الجزء الثاني من الكتاب.
هذا في الهداية بمعنى إراءة الطريق و أمّا الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب - و المطلوب في المقام الآثار الحسنة الّتي تترتّب على الاهتداء بهدى الله و التلبّس بالعبوديّة كالحياة الطيّبة المعجّلة في الدنيا و الحياة السعيدة الأبديّة في الآخرة - فمن البيّن أنّه من قبيل الصنع و الإيجاد الّذي يختصّ به تعالى فهو ممّا قضى به الله و أوجبه على نفسه و سجّله بوعده الحقّ قال تعالى:( فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فَلا يَضِلُّ وَ لا يَشْقى ) طه: 123، و قال:( مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ ) النحل: 97، و قال:( وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً
وَعْدَ اللهِ حَقًّا وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلًا ) النساء: 122.
و لا ينافي انتساب هذا المعنى من الهداية إليه تعالى بنحو الأصالة انتسابه إلى غيره تعالى بنحو التبع بتخلّل الأسباب بينه تعالى و بين ما ينسب إليه من الأثر بإذنه.
و معنى الآية - إن كان المراد بالهدى إراءة الطريق - أنّا إنّما نبيّن لكم ما نبيّن لأنّه من إراءة طريق العبوديّة و إراءة الطريق علينا، و إن كان المراد به الإيصال إلى المطلوب أنّا إنّما نيسّر هؤلاء لليسرى من الأعمال الصالحة أو من الحياة السهلة الأبديّة و دخول الجنّة لأنّه من إيصال الأشياء إلى غاياتها و علينا ذلك.
و أمّا التيسير للعسرى فهو ممّا يتوقّف عليه التيسير لليسرى( لِيَمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَ يَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ) الأنفال: 37 و قد قال سبحانه في القرآن الّذي هو هدى للعالمين:( وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً ) إسراء: 82.
و يمكن أن يكون المراد به مطلق الهداية أعمّ من الهداية التكوينيّة الحقيقيّة و التشريعيّة الاعتباريّة - على ما هو ظاهر إطلاق اللفظ - فله تعالى الهداية الحقيقيّة كما قال:( الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى ) طه: 50، و الهداية الاعتباريّة كما قال:( إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً ) الإنسان: 3.
و قوله:( وَ إِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَ الْأُولى ) أي عالم البدء و عالم العود فكلّ ما يصدق عليه أنّه شيء فهو مملوك له تعالى بحقيقة الملك الّذي هو قيام وجوده بربّه القيّوم و يتفرّع عليه الملك الاعتباري الّذي من آثاره جواز التصرّفات.
فهو تعالى يملك كلّ شيء من كلّ جهة فلا يملك شيء منه شيئاً فلا معارض يعارضه و لا مانع يمنعه و لا شيء يغلبه كما قال:( وَ اللهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ) الرعد: 41 و قال:( وَ اللهُ غالِبٌ عَلى أَمْرِهِ ) يوسف: 21، و قال:( وَ يَفْعَلُ اللهُ ما يَشاءُ ) إبراهيم: 27.
قوله تعالى: ( فَأَنْذَرْتُكُمْ ناراً تَلَظَّى لا يَصْلاها إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَ تَوَلَّى )
تفريع على ما تقدّم أي إذا كان الهدى علينا فأنذرتكم نار جهنّم و بذلك يوجّه ما في قوله:( فَأَنْذَرْتُكُمْ ) من الالتفات عن التكلّم مع الغير إلى التكلّم وحده أي إذا كان الهدى مقضيّة محتومة فالمنذر بالأصالة هو الله و إن كان بلسان رسوله.
و تلظّى النار تلهّبها و توهّجها، و المراد بالنار الّتي تتلظّى جهنّم كما قال تعالى:( كَلَّا إِنَّها لَظى ) المعارج: 15.
و المراد بالأشقى مطلق الكافر الّذي يكفر بالتكذيب و التولّي فإنّه أشقى من سائر من شقي في دنياه فمن ابتلي في بدنه شقي و من اُصيب في ماله أو ولده مثلاً شقي و من خسر في أمر آخرته شقي و الشقيّ في أمر آخرته أشقى من غيره لكون شقوته أبديّة لا مطمع في التخلص منها بخلاف الشقوة في شأن من شؤن الدنيا فإنّها مقطوعة لا محالة مرجوّة الزوال عاجلاً.
فالمراد بالأشقى هو الكافر المكذّب بالدعوة الحقّة المعرض عنها على ما يدلّ عليه توصيفه بقوله:( الَّذِي كَذَّبَ وَ تَوَلَّى ) و يؤيّده إطلاق الإنذار، و أمّا الأشقى بمعنى أشقى الناس كلّهم فممّا لا يساعد عليه السياق البتّة.
و المراد بصلي النار اتّباعها و لزومها فيفيد معنى الخلود و هو ممّا قضى الله به في حقّ الكافر، قال تعالى:( وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ ) البقرة: 39.
و بذلك يندفع ما قيل: إنّ قوله:( لا يَصْلاها إِلَّا الْأَشْقَى ) ينفي عذاب النار عن فسّاق المؤمنين على ما هو لازم القصر في الآية، وجه الاندفاع أنّ الآية إنّما تنفي عن غير الكافر الخلود فيها دون أصل الدخول.
قوله تعالى: ( وَ سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّى وَ ما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى ) التجنيب التبعيد، و ضمير( سَيُجَنَّبُهَا ) للنار، و المعنى سيبعد عن النار الأتقى.
و المراد بالأتقى من هو أتقى من غيره ممّن يتّقي المخاطر فهناك من يتّقي ضيعة النفوس كالموت و القتل و من يتّقي فساد الأموال و من يتّقي العدم و الفقر فيمسك عن
بذل المال و هكذا و منهم من يتّقي الله فيبذل المال، و أتقى هؤلاء الطوائف من يتّقي الله فيبذل المال لوجهه و إن شئت فقل يتّقي خسران الآخرة فيتزكّى بالإعطاء.
فالمفضّل عليه للأتقى هو من لا يتّقي بإعطاء المال و إن اتّقى سائر المخاطر الدنيويّة أو اتّقى الله بسائر الأعمال الصالحة.
فالآية عامّة بحسب مدلولها غير خاصّة و يدلّ عليه توصيف الأتقى بقوله:( الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ ) إلخ و هو وصف عامّ و كذا ما يتلوه، و لا ينافي ذلك كون الآيات أو جميع السورة نازلة لسبب خاصّ كما ورد في أسباب النزول.
و أمّا إطلاق المفضّل عليه بحيث يشمل جميع الناس من طالح أو صالح و لازمه انحصار المفضّل في واحد مطلقاً أو واحد في كلّ عصر، و يكون المعنى و سيجنّبها من هو أتقى الناس كلّهم و كذا المعنى في نظيره: لا يصلاها إلّا أشقى الناس كلّهم فلا يساعد عليه سياق آيات صدر السورة، و كذا الإنذار العامّ الّذي في قوله:( فَأَنْذَرْتُكُمْ ناراً تَلَظَّى ) فلا معنى لأن يقال: أنذرتكم جميعاً ناراً لا يخلد فيها إلّا واحد منكم جميعاً و لا ينجو منها إلّا واحد منكم جميعاً.
و قوله:( الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّى ) صفة للأتقى أي الّذي يعطي و ينفق ماله يطلب بذلك أن ينمو نماءً صالحاً.
و قوله:( وَ ما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى ) تقرير لمضمون الآية السابقة أي ليس لأحد عنده من نعمة تجزى تلك النعمة بما يؤتيه من المال و تكافأ و إنّما يؤتيه لوجه الله و يؤيّد هذا المعنى تعقيبه بقوله:( إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى ) .
فالتقدير من نعمة تجزى به، و إنّما حذف الظرف رعاية للفواصل، و يندفع بذلك ما قيل: إنّ بناء( تُجْزى ) للمفعول لأن القصد ليس لفاعل معيّن.
قوله تعالى: ( إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى ) استثناء منقطع و المعنى و لكنّه يؤتي ماله طلباً لوجه ربّه الأعلى و قد تقدّم كلام في معنى وجه الله تعالى و في معنى الاسم الأعلى.
قوله تعالى: ( وَ لَسَوْفَ يَرْضى ) أي و لسوف يرضى هذا الأتقى بما يؤتيه ربّه
الأعلى من الأجر الجزيل و الجزاء الحسن الجميل.
و في ذكر صفتي الربّ و الأعلى إشعار بأنّ ما يؤتاه من الجزاء أنعم الجزاء و أعلاه و هو المناسب لربوبيّته تعالى و علوّه، و من هنا يظهر وجه الالتفات في الآية السابقة في قوله:( وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى ) من سياق التكلّم وحده إلى الغيبة بالإشارة إلى الوصفين: ربّه الأعلى.
( بحث روائي)
في الكافي، بإسناده عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفرعليهالسلام : قول الله عزّوجلّ:( وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى ) ( وَ النَّجْمِ إِذا هَوى ) و ما أشبه ذلك؟ فقال: إنّ لله عزّوجلّ أن يقسم من خلقه بما شاء، و ليس لخلقه أن يقسموا إلّا به.
أقول: و رواه في الفقيه، بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن أبي جعفر الثانيعليهالسلام .
و في تفسير القمّيّ: في قوله تعالى:( وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى ) قال: حين يغشى النهار و هو قسم.
و عن الحميريّ في قرب الإسناد، عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضاعليهالسلام قال: سمعته يقول: في تفسير( وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى ) إنّ رجلاً كان لرجل في حائطه نخلة فكان يضرّ به فشكى ذلك إلى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فدعاه فقال: أعطني نخلتك بنخلة في الجنّة فأبى فسمع ذلك رجل من الأنصار يكنّى أبا الدحداح فجاء إلى صاحب النخلة فقال: بعني نخلتك بحائطي فباعه فجاءه إلى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فقال: يا رسول الله قد اشتريت نخلة فلان بحائطي فقال رسول الله: لك بدلها نخلة في الجنّة.
فأنزل الله تعالى على نبيّه:( وَ ما خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطى ) يعني النخلة( وَ اتَّقى وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى ) هو ما عند رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ( فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى - إلى قوله -تَرَدَّى ) .
أقول: و رواه القمّيّ في تفسيره، مرسلاً مضمراً، و قوله: الزوجين تفسير منهعليهالسلام
للذكر و الاُنثى.
و في تفسير القمّيّ: في قوله تعالى:( وَ سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ) قال: أبو الدحداح.
أقول: هذا ما من طرق الشيعة عن أئمّة أهل البيتعليهمالسلام .
و روى الطبرسيّ في مجمع البيان، القصّة عن الواحديّ بإسناده عن عكرمة عن ابن عبّاس و فيه أنّ الأنصاريّ ساوم صاحب النخلة في نخلة في نخلته ثمّ اشتراها منه بأربعين نخلة ثمّ وهبها للنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم فوهبها النبيّ لصاحب الدار، ثمّ روى الطبرسيّ عن عطاء أنّ اسم الرجل أبو الدحداح، و روى السيوطيّ في الدرّ المنثور، القصّة عن ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس و ضعّفه.
و قد ورد من طرق أهل السنّة أنّ السورة نزلت في أبي بكر قال الرازي في التفسير الكبير: أجمع المفسّرون منّا على أنّ المراد منه - يعني من الأتقى - أبو بكر، و اعلم أنّ الشيعة بأسرهم ينكرون هذه الرواية، و يقولون إنّما نزلت في حقّ عليّ بن أبي طالب و الدليل عليه قوله تعالى:( وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ ) فقوله:( الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّى ) إشارة إلى ما في تلك الآية من قوله:( وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ ) ثمّ أخذ الأتقى بمعنى أفضل الخلق أي أتقى الناس جميعاً و قد تقدّم الكلام فيه.
أمّا ما نسب إلى الشيعة بأسرهم من القول فالمعتمد عليه من طرقهم صحيح الحميريّ المتقدّم و ما في معناه من الروايات الدالّة على نزولها في أبي الدحداح الأنصاري.
نعم ورد في رواية ضعيفة عن البرقيّ عن إسماعيل بن مهران عن أيمن بن محرز عن أبي بصير عن أبي عبداللهعليهالسلام و فيها، و أمّا قوله:( وَ سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ) قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم و من تبعه، و( الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّى ) قال: ذاك أميرالمؤمنينعليهالسلام و هو قوله:( وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ ) و قوله:( وَ ما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى ) فهو رسول الله الّذي ليس لأحد عنده من نعمة تجزى و نعمته جارية على جميع الخلق صلوات الله عليه.
و الرواية على ضعف(1) سندها من قبيل الجري و التطبيق دون التفسير و من واضح الدليل عليه تطبيقه الموصوف على رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم و الوصف على عليّعليهالسلام ثمّ الآية التالية على النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم و لو كانت من التفسير لفسد بذلك النظم قطعاً. هذا لو كانت الواو في قوله:( و الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّى ) من الرواية و لو فرضت من الآية كانت الرواية من روايات التحريف المردودة.
و عن الحميريّ عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضاعليهالسلام قال، قلت: قول الله تبارك و تعالى( إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى ) قال: إنّ الله يهدي من يشاء و يضلّ من يشاء.
فقلت له: أصلحك الله إن قوماً من أصحابنا يزعمون أنّ المعرفة مكتسبة و أنّهم إن ينظروا من وجه النظر أدركوه.
فأنكر ذلك و قال: ما لهؤلاء القوم لا يكتسبون الخير لأنفسهم؟ ليس أحد من الناس إلّا و يجب أن يكون خيراً ممّن هو خير منه هؤلاء بنو هاشم موضعهم موضعهم و قرابتهم قرابتهم و هم أحقّ بهذا الأمر منكم أ فترى أنّهم لا ينظرون لأنفسهم؟ و قد عرفتم و لم يعرفوا.
قال أبوجعفر: لو استطاع الناس لأحبّونا.
أقول: أمّا الهداية - و المراد بها الإيصال إلى المطلوب - فهي لله تعالى لأنّها من شؤن الربوبيّة، و أمّا الإضلال و المراد به الإضلال على سبيل المجازاة دون الإضلال الابتدائيّ الّذي لا يضاف إليه تعالى فهو الله أيضاً لكونه إمساكاً عن إنزال الرحمة و عدماً للهداية و إذا كانت الهداية له فالإمساك عنه أيضاً منسوب إليه تعالى.
____________________
(1) أيمن بن محرز مجهول.
( سورة الضحى مكّيّة أو مدنيّة و هي إحدى عشرة آية)
( سورة الضحى الآيات 1 - 11)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالضُّحَىٰ ( 1 ) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ( 2 ) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ( 3 ) وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ( 4 ) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ( 5 ) أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ( 6 ) وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ( 7 ) وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ( 8 ) فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ( 9 ) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ( 10 ) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ( 11 )
( بيان)
قيل: انقطع الوحي عن النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم أيّاماً حتّى قالوا: إنّ ربّه ودّعه فنزلت السورة فطيّب الله بها نفسه، و السورة تحتمل المكّيّة و المدنيّة.
قوله تعالى: ( وَ الضُّحى وَ اللَّيْلِ إِذا سَجى ) إقسام، و الضحى - على ما في المفردات - انبساط الشمس و امتداد النهار و سمّي الوقت به، و سجو اللّيل سكونه و هو غشيان ظلمته.
قوله تعالى: ( ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ ما قَلى ) التوديع الترك، و القلى بكسر القاف البغض أو شدّته، و الآية جواب القسم، و مناسبة نور النهار و ظلمة الليل لنزول الوحي و انقطاعه ظاهرة.
قوله تعالى: ( وَ لَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولى ) في معنى الترقّي بالنسبة إلى ما تفيده الآية السابقة من كونهصلىاللهعليهوآلهوسلم على ما هو عليه من موقف الكرامة و العناية الإلهيّة كأنّه قيل: أنت على ما كنت عليه من الفضل و الرحمة ما دمت حيّاً في الدنيا و حياتك الآخرة خير لك من حياتك الدنيا.
قوله تعالى: ( وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى ) تقرير و تثبيت لقوله:( وَ لَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولى ) و قد اشتمل الوعد على عطاء مطلق يتبعه رضي مطلق.
و قيل: الآية ناظرة إلى الحياتين جميعاً دون الحياة الآخرة فقط.
قوله تعالى: ( أَ لَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوى ) الآية و ما يتلوها من الآيتين إشارة إلى بعض نعمه تعالى العظام عليهصلىاللهعليهوآلهوسلم فقد مات أبوه و هو في بطن اُمّه ثمّ ماتت اُمّه و هو ابن سنتين ثمّ مات جدّه الكفيل له و هو ابن ثمان سنين فكفّله عمّه و ربّاه.
و قيل: المراد باليتيم الوحيد الّذي لا نظير له في الناس كما يقال: درّ يتيم، و المعنى أ لم يجدك وحيداً بين الناس فآوى الناس إليك و جمعهم حولك.
قوله تعالى: ( وَ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدى ) المراد بالضلال عدم الهداية و المراد بكونهصلىاللهعليهوآلهوسلم ضالاً حالة في نفسه مع قطع النظر عن هدايته تعالى فلا هدى لهصلىاللهعليهوآلهوسلم و لا لأحد من الخلق إلّا بالله سبحانه فقد كانت نفسه في نفسها ضالّة و إن كانت الهداية الإلهيّة ملازمة لها منذ وجدت فالآية في معنى قوله تعالى:( ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَ لَا الْإِيمانُ ) الشورى: 52، و من هذا الباب قول موسى على ما حكى الله عنه:( فَعَلْتُها إِذاً وَ أَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ) الشعراء: 20 أي لم أهتد بهدى الرسالة بعد.
و يقرب منه ما قيل: إنّ المراد بالضلال الذهاب من العلم كما في قوله:( أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى ) البقرة: 282، و يؤيّده قوله:( وَ إِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغافِلِينَ ) يوسف: 3.
و قيل المعنى وجدك ضالاً بين الناس لا يعرفون حقّك فهداهم إليك و دلّهم عليك.
و قيل: إنّه إشارة إلى ضلاله في طريق مكّة حينما كانت تجيء به حليمة بنت أبي ذؤيب من البدو إلى جدّه عبدالمطلب على ما روي.
و قيل: إشارة إلى ما روي من ضلاله في شعاب مكّة صغيراً.
و قيل: إشارة إلى ما روي من ضلاله في مسيره إلى الشام مع عمّه أبي طالب في قافلة ميسرة غلام خديجة.
و قيل: غير ذلك و هي وجوه ضعيفة ظاهرة الضعف.
قوله تعالى: ( وَ وَجَدَكَ عائِلًا فَأَغْنى ) العائل الفقير الّذي لا مال له و قد كانصلىاللهعليهوآلهوسلم فقيراً لا مال له فأغناه الله بعد ما تزوّج بخديجة بنت خويلدعليهالسلام فوهبت له مالها و كان لها مال كثير، و قيل المراد بالإغناء استجابة دعوته.
قوله تعالى: ( فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ ) قال الراغب: القهر الغلبة و التذليل معاً و يستعمل في كلّ واحد منهما، انتهى.
قوله تعالى: ( وَ أَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ ) النهر هو الزجر و الردّ بغلظة.
قوله تعالى: ( وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ) التحديث بالنعمة ذكرها قولاً و إظهارها فعلاً و ذلك شكرها، و هذه الأوامر عامّة للناس و إن كانت موجّهة إلى النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم .
و الآيات الثلاث متفرّعة على الآيات الثلاث الّتي تسبقها و تذكر نعمه تعالى عليه كأنّه قيل: فقد وجدت ما يجده اليتيم من ذلّة اليتيم و انكساره فلا تقهر اليتيم باستذلاله في نفسه أو ماله، و وجدت مرارة حاجة الضالّ إلى الهدى و العائل إلى الغنى فلا تزجر سائلاً يسألك رفع حاجته إلى هدى أو معاش، و وجدت أنّ ما عندك نعمة أنعمها عليك ربّك بجوده و كرمه و رحمته فاشكر نعمته بالتحديث بها و لا تسترها.
( بحث روائي)
في تفسير القمّيّ: في قوله تعالى:( وَ الضُّحى ) قال: إذا ارتفعت الشمس( وَ اللَّيْلِ إِذا سَجى ) قال: إذا أظلم.
و فيه: في قوله تعالى( وَ ما قَلى ) قال: لم يبغضك.
و في الدرّ المنثور: في قوله تعالى:( وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى ) أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة
على الدنيا( وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى ) .
و فيه، أخرج العسكريّ في المواعظ و ابن لآل و ابن النجّار عن جابر بن عبدالله قال: دخل رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم على فاطمة و هي تطحن بالرحى و عليها كساء من حلّة الإبل فلمّا نظر إليها قال: يا فاطمة تعجّلي فتجرّعي مرارة الدنيا لنعيم الآخرة غداً فأنزل الله( وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى ) .
أقول: تحتمل الرواية نزول الآية وحدها بعد نزول بقيّة آيات السورة قبلها ثمّ الإلحاق و تحتمل نزولها وحدها ثانياً.
و فيه، أخرج ابن المنذر و ابن مردويه و أبونعيم في الحلية من طريق حرب بن شريح قال: قلت لأبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين: أ رأيت هذه الشفاعة الّتي يتحدّث بها أهل العراق أ حقّ هي؟ قال: إي و الله حدّثني عمّي محمّد بن الحنفيّة عن عليّ أنّ رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: أشفع لاُمّتي حتّى يناديني ربّي: أ رضيت يا محمّد؟ فأقول: نعم يا ربّ رضيت.
ثمّ أقبل عليّ فقال: إنّكم تقولون يا معشر أهل العراق: إنّ أرجى آية في كتاب الله:( يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً ) قلت: إنّا لنقول ذلك، قال: فكلّنا أهل البيت نقول: إنّ أرجى آية في كتاب الله( وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى ) الشفاعة.
و في تفسير البرهان، عن ابن بابويه بإسناده عن ابن الجهم عن الرضاعليهالسلام في مجلس المأمون قال: قال الله تعالى لنبيّه محمّدصلىاللهعليهوآلهوسلم :( أَ لَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوى ) يقول: أ لم يجدك وحيداً فآوى إليك الناس؟( وَ وَجَدَكَ ضَالًّا ) يعني عند قومك( فَهَدى ) أي هداهم إلى معرفتك؟( وَ وَجَدَكَ عائِلًا فَأَغْنى ) يقول: أغناك بأن جعل دعاءك مستجاباً؟ فقال المأمون: بارك الله فيك يا ابن رسول الله.
و فيه، عن البرقيّ بإسناده عن عمرو بن أبي نصر قال: حدّثني رجل من أهل البصرة قال: رأيت الحسين بن عليّعليهالسلام و عبدالله بن عمر يطوفان بالبيت فسألت ابن عمر فقلت: قول الله تعالى:( وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ) قال: أمره أن يحدّث بما
أنعم الله عليه.
ثمّ إنّي قلت للحسين بن عليّعليهالسلام : قول الله تعالى:( وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ) قال: أمره أن يحدّث بما أنعم الله عليه من دينه.
و في الدرّ المنثور، عن البيهقيّ عن الحسن بن عليّ في قوله:( وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ) قال: إذا أصبت خيراً فحدّث إخوانك.
و فيه، أخرج أبو داود عن جابر بن عبدالله عن النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: من أبلى بلاء فذكره فقد شكره و من كتمه فقد كفره، و من تحلّى بما لم يعط فإنّه كلابس ثوب زور.
( سورة أ لم نشرح مكّيّة أو مدنيّة و هي ثمان آيات)
( سورة الشرح الآيات 1 - 8)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ( 1 ) وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ( 2 ) الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ ( 3 ) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ( 4 ) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ( 5 ) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ( 6 ) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ( 7 ) وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ( 8 )
( بيان)
أمر بالنصب في الله و الرغبة إليه توصّل إليه بتقدّمة الامتنان و السورة تحتمل المكّيّة و المدنيّة و سياق آياتها أوفق للمدنيّة.
و في بعض الروايات عن أئمّة أهل البيتعليهمالسلام أنّ الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة، و يروى ذلك أيضاً عن طاووس و عمر بن عبد العزيز قال الرازيّ في التفسير الكبير بعد نقله عنهما و الّذي دعاهما إلى ذلك هو أنّ قوله تعالى:( أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ ) كالعطف على قوله:( أَ لَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً ) و ليس كذلك لأنّ الأوّل كان نزوله حال اغتمام الرسولصلىاللهعليهوآلهوسلم من إيذاء الكفّار فكانت حال محنة و ضيق صدر، و الثاني يقتضي أن يكون حال النزول منشرح الصدر طيّب القلب فأنّى يجتمعان انتهى.
و فيه أنّ المراد بشرح صدرهصلىاللهعليهوآلهوسلم في الآية جعله بحيث يسع ما يلقى إليه من الحقائق و لا يضيق بما ينزل عليه من المعارف و ما يصيبه من أذى الناس في تبليغها كما سيجيء لا طيب القلب و السرور كما فسّره.
و يدلّ على ذلك ما رواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : لقد سألت ربّي مسألة وددت أنّي لم أسأله قلت: أي ربّ أنّه
قد كان أنبياء قبلي منهم من سخّرت له الريح و منهم من كان يحيي الموتى. قال: فقال: أ لم أجدك يتيماً فآويتك؟ قال: قلت: بلى قال: أ لم أجدك ضالاً فهديتك؟ قال: قلت: بلى أي ربّ. قال: أ لم أشرح لك صدرك و وضعت عنك وزرك؟ قال: قلت: بلى أي ربّ، و للكلام تتمّة ستوافيك في تفسير سورة الإيلاف إن شاء الله تعالى.
قوله تعالى: ( أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ) قال الراغب: أصل الشرح بسط اللحم و نحوه يقال: شرحت اللحم و شرّحته و منه شرح الصدر أي بسطته بنور إلهيّ و سكينة من جهة الله و روح منه قال تعالى:( رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ) ( أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ) ( فَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ ) انتهى.
و ترتّب الآيات الثلاث الأوّل في مضامينها ثمّ تعليلها بقوله:( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ) الظاهر في الانطباق على حالهصلىاللهعليهوآلهوسلم في أوائل دعوته و أواسطها و أواخرها ثمّ تكرار التعليل ثمّ تفريع آيتي آخر السورة كلّ ذلك يشهد على كون المراد بشرح صدرهصلىاللهعليهوآلهوسلم بسطه بحيث يسع ما يلقى إليه من الوحي و يؤمر بتبليغه و ما يصيبه من المكاره و الأذى في الله، و بعبارة اُخرى جعل نفسه المقدّسة مستعدّة تامّة الاستعداد لقبول ما يفاض عليها من جانب الله تعالى.
قوله تعالى: ( وَ وَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ) الوزر الحمل الثقيل، و إنقاض الظهر كسره بحيث يسمع له صوت كما يسمع من السرير و نحوه عند استقرار شيء ثقيل عليه، و المراد به ظهور ثقل الوزر عليه ظهوراً بالغاً.
و وضع الوزر إذهاب ما يحسّ من ثقله و جملة:( وَ وَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ ) معطوفة على قوله:( أَ لَمْ نَشْرَحْ ) إلخ لما أنّ معناه قد شرحنا لك صدرك.
و المراد بوضع وزرهصلىاللهعليهوآلهوسلم على ما يفيده السياق - و قد أشرنا إليه - إنفاذ دعوته و إمضاء مجاهدته في الله بتوفيق الأسباب فإنّ الرسالة و الدعوة و ما يتفرّع على ذلك هي الثقل الّذي حمّله إثر شرح صدره.
و قيل: وضع الوزر إشارة إلى ما وردت به الرواية أنّ ملكين نزلاً عليه و فلقاً صدره و أخرجاً قلبه و طهّراه ثمّ ردّاه إلى محلّه و ستوافيك روايته.
و قيل: المراد بالوزر ما صدر عنهصلىاللهعليهوآلهوسلم قبل البعثة، و قيل: غفلته عن الشرائع و نحوها ممّا يتوقّف على الوحي مع تطلّبه، و قيل: حيرته في بعض الاُمور كأداء حقّ الرسالة، و قيل: الوحي و ثقله عليه في بادئ أمره، و قيل: ما كان يرى من ضلال قومه و عنادهم مع عجزه عن إرشادهم، و قيل: ما كان يرى من تعدّيهم و مبالغتهم في إيذائه، و قيل: همّه لوفاة عمّه أبي طالب و زوجه خديجة، و قيل: الوزر المعصية و رفع الوزر عصمته، و قيل: الوزر ذنب اُمته و وضعه غفرانه.
و هذه الوجوه بعضها سخيف و بعضها ضعيف لا يلائم السياق، و هي بين ما قيل به و بين ما احتمل احتمالاً.
قوله تعالى: ( وَ رَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ ) رفع الذكر إعلاؤه عن مستوى ذكر غيره من الناس و قد فعل سبحانه به ذلك، و من رفع ذكره أن قرن الله اسمهصلىاللهعليهوآلهوسلم باسمه فاسمه قرين اسم ربّه في الشهادتين اللّتين هما أساس دين الله، و على كلّ مسلم أن يذكره مع ربّه كلّ يوم في الصلوات الخمس المفروضة، و من اللطف وقوع الرفع بعد الوضع في الآيتين.
قوله تعالى: ( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ) لا يبعد أن يكون تعليلاً لما تقدّم من وضع الوزر و رفع الذكر فما حمّله الله من الرسالة و أمر به من الدعوة - و ذلك أثقل ما يمكن لبشر أن يحمله - كان قد اشتدّ عليه الأمر بذلك، و كذا تكذيب قومه دعوته و استخفافهم به و إصرارهم على إمحاء ذكره كان قد اشتدّ عليه فوضع الله وزره الّذي حمّله بتوفيق الناس لإجابة دعوته و رفع ذكره الّذي كانوا يريدون إمحاءه و كان ذلك جرياً على سنّته تعالى في الكون من الإتيان باليسر بعد العسر فعلّل رفع الشدّة عنهصلىاللهعليهوآلهوسلم بما أشار إليه من سنّته، و على هذا فاللّام في( العسر ) للجنس دون الاستغراق و لعلّ السنّة سنّة تحوّل الحوادث و تقلّب الأحوال و عدم دوامها.
و عن الزمخشريّ في الكشّاف، أنّ الفاء في( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ ) إلخ فصيحة و الكلام مسوق لتسليتهصلىاللهعليهوآلهوسلم بالوعد الجميل.
قال: كان المشركون يعيّرون رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم و المؤمنين بالفقر و الضيقة حتّى
سبق إلى ذهنه الشريف أنّهم رغبوا عن الإسلام لافتقار أهله و احتقارهم فذكّره سبحانه ما أنعم به عليه من جلائل النعم ثمّ قال:( إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ) كأنّه قال: خوّلناك ما خوّلناك فلا تيأس من فضل الله فإنّ مع العسر الّذي أنتم فيه يسرا.
و ظاهره أنّ اللّام في العسر للعهد دون الجنس و أنّ المراد باليسر ما رزقه الله المؤمنين بعد من الغنائم الكثيرة.
و هو ممنوع فذهنه الشريفصلىاللهعليهوآلهوسلم أجلّ من أن يخفى عليه حالهم و أنّهم إنّما يرغبون عن دعوته استكباراً على الحقّ و استعلاء على الله على أنّ القوم لم يرغبوا في الإسلام حتّى بعد ظهور شوكته و إثراء المؤمنين و قد أيأس الله نبيّه من إيمان أكثرهم حيث قال:( لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ - إلى أن قال -وَ سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ) يس: 10 و الآيات مكّيّة و قال:( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ) البقرة: 6 و الآية مدنيّة.
و لو حمل اليسر بعد العسر على شوكة الإسلام و رفعته بعد ضعته مع أخذ السورة مكّيّة لم يكن به كثير بأس.
قوله تعالى: ( إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ) تكرار للتأكيد و التثبيت و قيل: استئناف و ذكروا أنّ في الآيتين دلالة على أنّ مع العسر الواحد يسران بناء على أنّ المعرفة إذا اُعيدت ثانية في الكلام كان المراد بها عين الاُولى بخلاف النكرة كما أنّه لو قيل: إذا اكتسبت الدرهم أو درهما فأنفق الدرهم كان المراد بالثاني هو الأوّل بخلاف ما لو قيل: إذا اكتسبت درهما فأنفق درهما و ليست القاعدة بمطّردة.
و التنوين في( يُسْراً ) للتنويع لا للتفخيم كما ذكره بعضهم، و المعيّة معيّة التوالي دون المعيّة بمعنى التحقّق في زمان واحد.
قوله تعالى: ( فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَ إِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ ) خطاب للنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم متفرّع على ما بيّن قبل من تحميله الرسالة و الدعوة و منّه تعالى عليه بما منّ من شرح الصدر و وضع الوزر و رفع الذكر و كلّ ذلك من اليسر بعد العسر.
و عليه فالمعنى إذا كان العسر يأتي بعده اليسر و الأمر فيه إلى الله لا غير فإذا فرغت
ممّا فرض عليك فأتعب نفسك في الله - بعبادته و دعائه - و ارغب فيه ليمنّ عليك بما لهذا التعب من الراحة و لهذا العسر من اليسر.
و قيل: المراد إذا فرغت من الفرائض فانصب في النوافل، و قيل: إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء، و ما يتضمّنه القولان بعض المصاديق.
و قيل: المعنى إذا فرغت من الغزو فاجتهد في العبادة و قيل: المراد إذا فرغت من دنياك فانصب في آخرتك و قيل غير ذلك و هي وجوه ضعيفة.
( بحث روائي)
في الدرّ المنثور، أخرج عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد عن اُبيّ بن كعب أنّ أبا هريرة قال: يا رسول الله ما أوّل ما رأيت من أمر النبوّة؟ فاستوى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم جالساً و قال: لقد سألت أبا هريرة إنّي لفي صحراء ابن عشرين سنة و أشهرا إذا بكلام فوق رأسي و إذا رجل يقول لرجل: أ هو هو؟ فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قطّ، و أرواح لم أجدها في خلق قطّ و ثياب لم أجدها على أحد قطّ فأقبلا إليّ يمشيان حتّى أخذ كلّ واحد منهما بعضدي لا أجد لأحدهما مسّاً.
فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه فأضجعني بلا قصر و لا هصر فقال أحدهما: أفلق صدره فحوّى أحدهما إلى صدري ففلقه فيما أرى بلا دم و لا وجع فقال له: أخرج الغلّ و الحسد فأخرج شيئاً كهيئة العلقة ثمّ نبذها فطرحها فقال له: أدخل الرأفة و الرحمة فإذا مثل الّذي أخرج شبه الفضّة ثمّ هزّ إبهام رجلي اليمنى و قال: اغد و أسلم فرجعت بها أغدو بها رقّة على الصغير و رحمة للكبير.
أقول: و في نقل بعضهم - كما في روح المعاني - ابن عشر حجج مكان قوله: ابن عشرين سنة و أشهراً، و في بعض الروايات نقل القصّة عند نزول سورة اقرأ باسم ربّك و في بعضها كما في صحيح البخاريّ و مسلم و الترمذيّ و النسائيّ نقل القصّة عند إسراء النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم .
و القصّة على أيّ حال من قبيل التمثّل بلا إشكال، و قد أطالوا البحث في توجيه
ما تتضمّنه على أنّها واقعة مادّيّة فتمحّلوا بوجوه لا جدوى في التعرّض لها بعد فساد أصلها.
و فيه، أخرج أبويعلى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن حبّان و ابن مردويه و أبو نعيم في الدلائل عن أبي سعيد الخدريّ عن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: أتاني جبرئيل فقال: إنّ ربّك يقول: تدري كيف رفعت ذكرك؟ قلت: الله أعلم قال: إذا ذكرت ذكرت معي.
و فيه، أخرج عبد الرزّاق و ابن جرير و الحاكم و البيهقيّ عن الحسن قال: خرج النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم يوماً مسروراً و هو يضحك و يقول: لن يغلب عسر يسرين( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ) .
و في المجمع: في قوله تعالى:( فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَ إِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ ) معناه فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربّك في الدعاء و ارغب إليه في المسألة. قال: و هو المرويّ عن أبي جعفر و أبي عبداللهعليهماالسلام .
( سورة التين مكّيّة و هي ثمان آيات)
( سورة التين الآيات 1 - 8)
بِّسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ( 1 ) وَطُورِ سِينِينَ ( 2 ) وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ( 3 ) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ( 4 ) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ( 5 ) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ( 6 ) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ( 7 ) أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ( 8 )
( بيان)
تذكر السورة البعث و الجزاء و تسلك إليه من طريق خلق الإنسان في أحسن تقويم ثمّ اختلافهم بالبقاء على الفطرة الاُولى و خروجهم منها بالانحطاط إلى أسفل سافلين و وجوب التمييز بين الطائفتين جزاء باقتضاء الحكمة.
و السورة مكّيّة و تحتمل المدنيّة و يؤيّد نزولها بمكّة قوله:( وَ هذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ) و ليس بصريح فيه لاحتمال نزولها بعد الهجرة و هوصلىاللهعليهوآلهوسلم بمكّة.
قوله تعالى: ( وَ التِّينِ وَ الزَّيْتُونِ وَ طُورِ سِينِينَ وَ هذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ) قيل: المراد بالتين و الزيتون الفاكهتان المعروفتان أقسم الله بهما لما فيهما من الفوائد الجمّة و الخواصّ النافعة، و قيل المراد بهما شجرتا التين و الزيتون، و قيل: المراد بالتين الجبل الّذي عليه دمشق و بالزيتون الجبل الّذي عليه بيت المقدس، و لعلّ إطلاق اسم الفاكهتين على الجبلين لكونهما منبتيهما و لعلّ الإقسام بهما لكونهما مبعثي جمّ غفير من الأنبياء و قيل غير ذلك.
و المراد بطور سينين الجبل الّذي كلّم الله تعالى فيه موسى بن عمرانعليهالسلام ، و يسمّى أيضاً طور سيناء.
و المراد بهذا البلد الأمين مكّة المشرّفة لأنّ الأمن خاصّة مشرّعة للحرم و هي فيه قال تعالى:( أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً ) العنكبوت: 67 و في دعاء إبراهيمعليهالسلام على ما حكى الله عنه:( رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً ) البقرة: 126، و في دعائه ثانياً:( رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً ) إبراهيم: 35.
و في الإشارة بهذا إلى البلد تثبيت التشريف عليه بالتشخيص و توصيفه بالأمين إمّا لكونه فعيلاً بمعنى الفاعل و يفيد معنى النسبة و المعنى ذي الأمن كاللابن و التامر و إمّا لكونه فعيلاً بمعنى المفعول و المراد البلد الّذي يؤمن الناس فيه أي لا يخاف فيه من غوائلهم ففي نسبة الأمن إلى البلد نوع تجوّز.
قوله تعالى: ( لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ) جواب للقسم و المراد بكون خلقه في أحسن تقويم اشتمال التقويم عليه في جميع شؤونه و جهات وجوده، و التقويم جعل الشيء ذا قوام و قوام الشيء ما يقوم به و يثبت فالإنسان و المراد به الجنس ذو أحسن قوام بحسب الخلقة.
و معنى كونه ذا أحسن قوام بحسب الخلقة على ما يستفاد من قوله بعد:( ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ ) إلخ صلوحه بحسب الخلقة للعروج إلى الرفيع الأعلى و الفوز بحياة خالدة عند ربّه سعيدة لا شقوة معها، و ذلك بما جهّزه الله به من العلم النافع و مكّنه منه من العمل الصالح قال تعالى:( وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها ) الشمس: 8 فإذا آمن بما علم و زاول صالح العمل رفعه الله إليه كما قال:( إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ) فاطر: 10، و قال:( وَ لكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ ) الحجّ: 37. و قال:( يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ ) المجادلة: 11 و قال:( فَأُولئِكَ لَهُمُ الدَّرَجاتُ الْعُلى ) طه: 75 إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على ارتفاع مقام الإنسان و ارتقائه بالإيمان و العمل الصالح عطاء من الله غير مجذوذ، و قد سمّاه تعالى أجرا كما يشير إليه قوله الآتي:( فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ) .
قوله تعالى: ( ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ ) ظاهر الردّ أن يكون بمعناه المعروف فأسفل منصوب بنزع الخافض، و المراد بأسفل سافلين مقام منحطّ هو أسفل من سفل
من أهل الشقوة و الخسران و المعنى ثمّ رددنا الإنسان إلى أسفل من سفل من أهل العذاب.
و احتمل أن يكون الردّ بمعنى الجعل أي جعلناه أسفل سافلين، و أن يكون بمعنى التغيير و المعنى ثمّ غيّرناه حال كونه أسفل جمع سافلين، و المراد بالسفالة على أيّ حال الشقاء و العذاب.
و قيل: المراد بخلق الإنسان في أحسن تقويم ما عليه وجوده أوان الشباب من استقامة القوى و كمال الصورة و جمال الهيئة، و بردّه إلى أسفل سافلين ردّه إلى الهرم بتضعيف قواه الظاهرة و الباطنة و نكس خلقته فتكون الآية في معنى قوله تعالى:( وَ مَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ) يس: 68.
و فيه أنّه لا يلائمه ما في قوله:( إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ) من الاستثناء الظاهر في المتّصل فإنّ حكم الخلق عامّ في المؤمن و الكافر و الصالح و الطالح و دعوى أنّ المؤمن أو المؤمن الصالح مصون من ذلك مجازفة.
و كذا القول بأنّ المراد بالإنسان هو الكافر و المراد بالردّ ردّه إلى جهنّم أو إلى نكس الخلق و الاستثناء منقطع.
قوله تعالى: ( إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ) أي غير مقطوع استثناء متّصل من جنس الإنسان، و تفريع قوله:( فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ) عليه يؤيّد كون المراد من ردّه إلى أسفل سافلين ردّه إلى الشقاء و العذاب.
قوله تعالى: ( فَما يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَ لَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ ) الخطاب للإنسان باعتبار الجنس، و قيل للنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم و المراد غيره، و( فَما ) استفهاميّة توبيخيّة، و( بِالدِّينِ ) متعلّق بيكذّبك، و الدين الجزاء و المعنى - على ما قيل - ما الّذي يجعلك مكذّباً بالجزاء يوم القيامة بعد ما جعلنا الإنسان طائفتين طائفة مردودة إلى أسفل سافلين و طائفة مأجورة أجراً غير ممنون.
و قوله:( أَ لَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ ) الاستفهام للتقرير و كونه تعالى أحكم الحاكمين هو كونه فوق كلّ حاكم في إتقان الحكم و حقيّته و نفوذه من غير اضطراب
و وهن و بطلان فهو تعالى يحكم في خلقه و تدبيره بما من الواجب في الحكمة أن يحكم به الناس من حيث الإتقان و الحسن و النفوذ و إذا كان الله تعالى أحكم الحاكمين و الناس طائفتان مختلفتان اعتقاداً و عملاً فمن الواجب في الحكمة أن يميّز بينهم بالجزاء في حياتهم الباقية و هو البعث.
فالتفريع في قوله:( فَما يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ) من قبيل تفريع النتيجة على الحجّة و قوله:( أَ لَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ ) تتميم للحجّة المشار إليها بما يتوقّف عليه تمامها.
و المحصّل أنّه إذا كان الناس خلقوا في أحسن تقويم ثمّ اختلفوا فطائفة خرجت عن تقويمها الأحسن و ردّت إلى أسفل سافلين و طائفة بقيت في تقويمها الأحسن و على فطرتها الاُولى و الله المدبّر لأمرهم أحكم الحاكمين، و من الواجب في الحكمة أن تختلف الطائفتان جزاء، فهناك يوم تجزى فيه كلّ طائفة بما عملت و لا مسوّغ للتكذيب به.
فالآيات - كما ترى - في معنى قوله تعالى:( أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ) ص: 28، و قوله:( أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَواءً مَحْياهُمْ وَ مَماتُهُمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ ) الجاثية: 21.
و بعض من جعل الخطاب في قوله:( فَما يُكَذِّبُكَ ) للنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم جعل( ما ) بمعنى من و الحكم بمعنى القضاء، و عليه فالمعنى إذا كان الناس مختلفين و لازم ذلك اختلاف جزائهم في يوم معدّ للجزاء فمن الّذي ينسبك إلى الكذب بالجزاء أ ليس الله بأقضى القاضين فهو يقضي بينك و بين المكذّبين لك بالدين.
و أنت خبير بأنّ فيه تكلّفاً من غير موجب.
( بحث روائي)
في تفسير القمّيّ: في قوله تعالى:( وَ التِّينِ وَ الزَّيْتُونِ وَ طُورِ سِينِينَ وَ هذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ) التين المدينة و الزيتون بيت المقدس و طور سينين الكوفة و هذا البلد الأمين مكّة.
أقول: و قد ورد هذا المعنى في بعض الروايات عن موسى بن جعفر عن آبائهعليهمالسلام عن النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم و لا يخلو من شيء، و في بعضها: أنّ التين و الزيتون الحسن و الحسين و الطور عليّ و البلد الأمين النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم و ليس من التفسير في شيء.
و في الدرّ المنثور، أخرج ابن مردويه عن جابر بن عبدالله أنّ خزيمة بن ثابت و ليس بالأنصاريّ سأل النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم عن البلد الأمين فقال: مكّة.
( سورة العلق مكّيّة و هي تسع عشرة آية)
( سورة العلق الآيات 1 - 19)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ( 1 ) خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ( 2 ) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ( 3 ) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ( 4 ) عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ( 5 ) كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ ( 6 ) أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ ( 7 ) إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ( 8 ) أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ( 9 ) عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ( 10 ) أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ( 11 ) أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ( 12 ) أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ( 13 ) أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللهَ يَرَىٰ ( 14 ) كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ( 15 ) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ( 16 ) فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ( 17 ) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ( 18 ) كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب ( 19 )
( بيان)
أمر للنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم بتلقّي القرآن بالوحي منه تعالى و هي أوّل سورة نزلت من القرآن، و سياق آياتها لا يأبى نزولها دفعة واحدة كما سنشير إليه، و هي مكّيّة قطعاً.
قوله تعالى: ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ ) قال الراغب: و القراءة ضمّ الحروف و الكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل، و ليس يقال ذلك لكلّ جمع لا يقال: قرأت القوم إذا جمعتهم، و يدلّ على ذلك أنّه لا يقال: للحرف الواحد إذا تفوّه به: قراءة انتهى.
و على أيّ حال، يقال: قرأت الكتاب إذا جمعت ما فيه من الحروف و الكلمات بضمّ بعضها إلى بعض في الذهن و إن لم تتلفّظ بها، و يقال: قرأته إذا جمعت الحروف و الكلمات بضمّ بعضها إلى بعض في التلفّظ، و يقال قرأته عليه إذا جمعت بين حروفه و كلماته في سمعه و يطلق عليها بهذا المعنى التلاوة أيضاً قال تعالى:( رَسُولٌ مِنَ اللهِ يَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً ) البينة: 2.
و ظاهر إطلاق قوله:( اقْرَأْ ) المعنى الأوّل و المراد به الأمر بتلقّي ما يوحيه إليه ملك الوحي من القرآن فالجملة أمر بقراءة الكتاب و هي من الكتاب كقول القائل في مفتتح كتابه لمن أرسله إليه: اقرأ كتابي هذا و اعمل به فقوله هذا أمر بقراءة الكتاب و هو من الكتاب.
و هذا السياق يؤيّد أوّلاً ما ورد أنّ الآيات أوّل ما نزل من القرآن على النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم .
و ثانياً أنّ التقدير اقرأ القرآن أو ما في معناه، و ليس المراد مطلق القراءة باستعمال( اقرأ ) استعمال الفعل اللازم بالإعراض عن المفعول، و لا المراد القراءة على الناس بحذف المتعلّق و إن كان ذلك من أغراض النزول كما قال:( وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلى مُكْثٍ وَ نَزَّلْناهُ تَنْزِيلًا ) إسراء: 106، و لا أنّ قوله:( بِاسْمِ رَبِّكَ ) مفعول( اقْرَأْ ) و الباء زائدة و التقدير اقرأ اسم ربّك أي بسمل.
و قوله:( بِاسْمِ رَبِّكَ ) متعلّق بمقدّر نحو مفتتحاً و مبتدئاً أو باقرأ و الباء للملابسة و لا ينافي ذلك كون البسملة المبتدأة بها السورة جزء من السورة فهي من كلام الله افتتح سبحانه بها و أمر أن يقرأ مبتدئا بها كما أمر أن يقرأ قوله:( اقْرَأْ بِاسْمِ ) إلخ ففيه تعليم بالعمل نظير الأمر بالاستثناء في قوله:( وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ ) الكهف: 24 فافهم ذلك.
و في: قوله( رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ) إشارة إلى قصر الربوبيّة في الله عزّ اسمه و هو توحيد الربوبيّة المقتضية لقصر العبادة فيه فإنّ المشركين كانوا يقولون: إنّ الله سبحانه ليس له إلّا الخلق و الإيجاد و أمّا الربوبيّة و هي الملك و التدبير فلمقرّبي
خلقه من الملائكة و الجنّ و الإنس فدفعه الله بقوله:( رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ) الناصّ على أنّ الربوبيّة و الخلق له وحده.
و قوله:( خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ ) المراد جنس الإنسان المتناسل و العلق الدم المنجمد و المراد به ما يستحيل إليه النطفة في الرحم.
ففي الآية إشارة إلى التدبير الإلهيّ الوارد على الإنسان من حين كان علقة إلى حين يصير إنساناً تامّاً كاملاً له من أعاجيب الصفات و الأفعال ما تتحيّر فيه العقول فلم يتمّ الإنسان إنساناً و لم يكمل إلّا بتدبير متعاقب منه تعالى و هو بعينه خلق بعد خلق فهو تعالى ربّ مدبّر لأمر الإنسان بعين أنّه خالق له فليس للإنسان إلّا أن يتّخذه وحده ربّاً ففي الكلام احتجاج على توحيد الربوبيّة.
قوله تعالى: ( اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ ) أمر بالقراءة ثانياً تأكيداً للأمر الأوّل على ما هو ظاهر سياق الإطلاق.
و قيل: المراد به الأمر بالقراءة على الناس و هو التبليغ بخلاف الأمر الأوّل فالمراد به الأمر بالقراءة لنفسه، كما قيل: إنّ المراد بالأمرين جميعاً الأمر بالقراءة على الناس، و الوجهان غير ظاهرين.
و قوله:( وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ ) أي الّذي يفوق عطاؤه عطاء ما سواه فهو تعالى يعطي لا عن استحقاق و ما من نعمة إلّا و ينتهي إيتاؤها إليه تعالى.
و قوله:( الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ) الباء للسببيّة أي علّم القراءة أو الكتابة و القراءة بواسطة القلم و الجملة حاليّة أو استئنافيّة، و الكلام مسوق لتقوية نفس النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم و إزالة القلق و الاضطراب عنها حيث اُمر بالقراءة و هو اُمّيّ لا يكتب و لا يقرأ كأنّه قيل: اقرأ كتاب ربّك الّذي يوحيه إليك و لا تخف و الحال أنّ ربّك الأكرم الّذي علم الإنسان القراءة بواسطة القلم الّذي يخطّ به فهو قادر على أن يعلّمك قراءة كتابه و أنت اُمّيّ و قد أمرك بالقراءة و لو لم يقدرك عليها لم يأمرك بها.
ثمّ عمّم سبحانه النعمة فذكر تعليمه للإنسان ما لم يعلم فقال:( عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ ) و فيه مزيد تقوية لقلب النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم و تطييب لنفسه.
و المراد بالإنسان الجنس كما هو ظاهر السياق و قيل: المراد به آدمعليهالسلام ، و قيل: إدريسعليهالسلام لأنّه أوّل من خطّ بالقلم، و قيل: كلّ نبيّ كان يكتب و هي وجوه ضعيفة بعيدة عن الفهم.
قوله تعالى: ( كَلَّا إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى ) ردع عمّا يستفاد من الآيات السابقة أنّه تعالى أنعم على الإنسان بعظائم نعم مثل التعليم بالقلم و سائر ما علم و التعليم من طريق الوحي فعلى الإنسان أن يشكره على ذلك لكنّه يكفر بنعمته تعالى و يطغى.
و قوله:( إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى ) أن يتعدّى طوره، و هو إخبار بما في طبع الإنسان ذلك كقوله:( إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ) إبراهيم: 34.
و قوله:( أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى ) من الرأي دون الرؤية البصريّة، و فاعل( رَآهُ ) و مفعوله الإنسان. و جملة( أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى ) في مقام التعليل أي ليطغى لأنّه يعتقد نفسه مستغنياً عن ربّه المنعم عليه فيكفر به، و ذلك أنّه يشتغل بنفسه و الأسباب الظاهريّة الّتي يتوصّل بها إلى مقاصده فيغفل عن ربّه من غير أن يرى حاجة منه إليه تبعثه إلى ذكره و شكره على نعمه فينساه و يطغى.
قوله تعالى: ( إِنَّ إِلى رَبِّكَ الرُّجْعى ) الرجعى هو الرجوع و الظاهر من سياق الوعيد الآتي أنّه وعيد و تهديد بالموت و البعث، و الخطاب للنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم ، و قيل: الخطاب للإنسان بطريق الالتفات للتشديد، و الأوّل أظهر.
قوله تعالى: ( أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى عَبْداً إِذا صَلَّى أَ رَأَيْتَ إِنْ كانَ عَلَى الْهُدى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوى أَ رَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّى أَ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرى ) بمنزلة ذكر بعض المصاديق للإنسان الطاغي و هو كالتوطئة لوعيده بتصريح العقاب و النهي عن طاعته و الأمر بعبادته تعالى، و المراد بالعبد الّذي كان يصلّي هو النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم على ما يستفاد من آخر الآيات حيث ينهاهصلىاللهعليهوآلهوسلم عن طاعة ذلك الناهي و يأمره بالسجود و الاقتراب.
و سياق الآيات - على تقدير كون السورة أوّل ما نزل من القرآن و نزولها دفعة واحدة - يدلّ على صلاة النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم قبل نزول القرآن و فيه دلالة على نبوّته
قبل رسالته بالقرآن.
و أمّا ما ذكره بعضهم أنّه لم يكن الصلاة مفروضة في أوّل البعثة و إنّما شرّعت ليلة المعراج على ما في الأخبار و هو قوله تعالى:( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ ) إسراء: 78.
ففيه أنّ المسلّم من دلالتها أنّ الصلوات الخمس اليوميّة إنّما فرضت بهيئتها الخاصّة ركعتين ركعتين ليلة المعراج و لا دلالة فيها على عدم تشريعها قبل و قد ورد في كثير من السور المكّيّة و منها النازلة قبل سورة الإسراء كالمدّثّر و المزّمّل و غيرهما ذكر الصلاة بتعبيرات مختلفة و إن لم يظهر فيها من كيفيّتها إلّا أنّها كانت مشتملة على تلاوة شيء من القرآن و السجود.
و قد ورد في بعض الروايات صلاة النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم مع خديجة و عليّ في أوائل البعثة و إن لم يذكر كيفيّة صلاتهم.
و بالجملة قوله:( أَ رَأَيْتَ) بمعنى أخبرني، و الاستفهام للتعجيب، و المفعول الأوّل لقوله:( أَ رَأَيْتَ ) الأوّل قوله:( الَّذِي يَنْهى ) و لأرأيت الثالث ضمير عائد إلى الموصول، و لأرأيت الثاني ضمير عائد إلى قوله:( عَبْداً ) و المفعول الثاني لأرأيت في المواضع الثلاث قوله:( أَ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرى ) .
و محصّل معنى الآيات أخبرني عن الّذي ينهى عبداً إذا صلّى و عبدالله الناهي يعلم أنّ الله يرى ما يفعله كيف يكون حاله. أخبرني عن هذا الناهي إن كان ذاك العبد المصلّي على الهدى أو أمر بالتقوى كيف يكون حال هذا الناهي و هو يعلم أنّ الله يرى. أخبرني عن هذا الناهي أن تلبّس بالتكذيب للحقّ و التولّي عن الإيمان به و نهي العبد المصلّي عن الصلاة و هو يعلم أنّ الله يرى؟ هل يستحقّ إلّا العذاب؟
و قيل: المفعول الأوّل لأرأيت في جميع المواضع الثلاث هو الموصول أو الضمير العائد إليه تحرّزاً عن التفكيك بين الضمائر.
و الأولى على هذا أن يجعل معنى قوله:( أَ رَأَيْتَ إِنْ كانَ عَلَى الْهُدى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوى ) أخبرني عن هذا الناهي إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى و هو يعلم أنّ
الله يرى ما ذا كان يجب عليه أن يفعله و يأمر به؟ و كيف يكون حاله و قد نهى عن عبادة الله سبحانه؟
و هو مع ذلك معنى بعيد و لا بأس بالتفكيك بين الضمائر مع مساعدة السياق و إعانة القرائن.
و قوله:( أَ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرى ) المراد به العلم على طريق الاستلزام فإنّ لازم الاعتقاد بأنّ الله خالق كلّ شيء هو الاعتقاد بأنّ له علماً بكلّ شيء و إن غفل عنه و قد كان الناهي وثنيّاً مشركاً و الوثنيّة معترفون بأنّ الله هو خالق كلّ شيء و ينزّهونه عن صفات النقص فيرون أنّه تعالى لا يجهل شيئاً و لا يعجز عن شيء و هكذا.
قوله تعالى: ( كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ ) قال في المجمع: و السفع الجذب الشديد يقال: سفعت بالشيء إذا قبضت عليه و جذبته جذباً شديداً. انتهى، و في توصيف الناصية بالكذب و الخطإ و هما وصفا صاحب الناصية مجاز.
و في الكلام ردع و تهديد شديد، و المعنى ليس الأمر كما يقول و يريد أو ليس له ذلك. اُقسم لئن لم يكفّ عن نهيه و لم ينصرف لنأخذنّ بناصيته أخذ الذليل المهان و نجذبنّه إلى العذاب تلك الناصية الّتي صاحبها كاذب فيما يقول خاطئ فيما يفعل، و قيل: المعنى لنسمنّ ناصيته بالنار و نسوّدنّها.
قوله تعالى: ( فَلْيَدْعُ نادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ ) النادي المجلس و كأنّ المراد به أهل المجلس أي الجمع الّذين يجتمع بهم، و قيل: الجليس، و الزبانية الملائكة الموكّلون بالنار، و قيل: الزبانية في كلامهم الشرط، و الأمر تعجيزيّ اُشير به إلى شدّة الأخذ و المعنى فليدع هذا الناهي جمعه لينجّوه منّا سندع الزبانية الغلاظ الشداد الّذين لا ينفع معهم نصر ناصر.
قوله تعالى: ( كَلَّا لا تُطِعْهُ وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ ) تكرار الردع للتأكيد، و قوله:( لا تُطِعْهُ ) أي لا تطعه في النهي عن الصلاة و هي القرينة على أنّ المراد بالسجود الصلاة، و لعلّ الصلاة الّتي كانصلىاللهعليهوآلهوسلم يأتي بها يومئذ كانت تسبيحه تعالى و السجود له
و قيل: المراد به السجود لقراءة هذه السورة الّتي هي إحدى العزائم الأربع في القرآن.
و الاقتراب التقرّب إلى الله، و قيل: الاقتراب من ثواب الله تعالى.
( بحث روائي)
في الدرّ المنثور، أخرج عبد الرزّاق و أحمد و عبد بن حميد و البخاريّ و مسلم و ابن جرير و ابن الأنباريّ في المصاحف و ابن مردويه و البيهقيّ من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنّها قالت: أوّل ما بدئ به رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلّا جاءت مثل فلق الصبح.
ثمّ حبّب إليه الخلاء و كان يخلو بغار حراء فيتحنّث فيه و هو التعبّد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله و يتزوّد لذلك ثمّ يرجع إلى خديجة فيتزوّد لمثلها حتّى جاءه الحقّ و هو في غار حراء فجاءه الملك فقال: اقرأ قال: قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطّني حتّى بلغ منّي الجهد ثمّ أرسلني فقال: اقرأ فقلت: ما أنا بقارئ قال: فأخذني فغطّني الثانية حتّى بلغ منّي الجهد ثمّ أرسلني فقال: اقرأ فقلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغطّني الثالثة حتّى بلغ منّي الجهد ثمّ أرسلني فقال:( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ) الآية.
فرجع بها رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زمّلوني زمّلوني فزمّلوه حتّى ذهب عنه الروع فقال لخديجة و أخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة: كلّا ما يخزيك الله أبداً إنّك لتصل الرحم و تحمل الكلّ و تكسب(1) المعدوم و تقري الضيف و تعين على نوائب الحق(2) .
____________________
(1) تكسي ط.
(2) الخلق ط.
فانطلقت به خديجة حتّى أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزّى ابن عمّ خديجة و كان امرأ قد تنصّر في الجاهليّة، و كان يكتب الكتاب العبرانيّ فيكتب من الإنجيل بالعبرانيّة ما شاء الله أن يكتب، و كان شيخاً كبيراً قد عمي فقالت له خديجة: يا ابن عمّ اسمع من ابن أخيك.
فقال له ورقة: يا ابن أخي ما ذا ترى؟ فأخبره رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم خبر ما رأى فقال له ورقة: هذا الناموس الّذي أنزل الله على موسى! يا ليتني أكون فيها جذعاً يا ليتني أكون فيها حيّاً إذ يخرجك قومك فقال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : أ و مخرجيّ هم؟ قال: نعم لم يأت رجل قطّ بمثل ما جئت به إلّا عودي، و إن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً ثمّ لم ينشب ورقة أن توفي و فتر الوحي.
قال ابن شهاب: و أخبرني أبوسلمة بن عبد الرحمن أنّ جابر بن عبدالله الأنصاري قال و هو يحدّث عن فترة الوحي فقال في حديثه: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الّذي جاءني بحراء جالس على كرسيّ بين السماء و الأرض فرعبت منه فرجعت فقلت: زمّلوني زمّلوني فأنزل الله:( يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ ) فحمي الوحي و تتابع.
و فيه، أخرج ابن أبي شيبة و ابن جرير و أبو نعيم في الدلائل عن عبدالله بن شدّاد قال: أتى جبريل محمّداًصلىاللهعليهوآلهوسلم فقال: يا محمّد اقرأ. قال: و ما أقرأ فضمّه ثمّ قال: يا محمّد اقرأ. قال: و ما أقرأ. قال:( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ) . حتّى بلغ( ما لَمْ يَعْلَمْ ) .
فجاء إلى خديجة فقال: يا خديجة ما أراه إلّا قد عرض لي قالت: كلّا و الله ما كان ربّك يفعل ذلك بك و ما أتيت فاحشة قطّ فأتت خديجة ورقة فأخبرته الخبر قال: لئن كنت صادقة إنّ زوجك لنبيّ و ليلقينّ من اُمّته شدّة و لئن أدركته لاُؤمننّ به.
قال: ثمّ أبطأ عليه جبريل فقالت خديجة: ما أرى ربّك إلّا قد قلاك فأنزل الله( وَ الضُّحى وَ اللَّيْلِ إِذا سَجى ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ ما قَلى ) .
أقول: و في رواية: أنّ الّذي ألقاه جبريل سورة الحمد.
و القصّة لا تخلو من شيء و أهون ما فيها من الإشكال شكّ النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم في كون ما شاهده وحياً إلهيّاً من ملك سماويّ ألقى إليه كلام الله و تردّده بل ظنّه أنّه من مسّ الشياطين بالجنون، و أشكل منه سكون نفسه في كونه نبوّة إلى قول رجل نصرانيّ مترهّب و قد قال تعالى:( قُلْ إِنِّي عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي ) الأنعام: 57 و أي حجّة بيّنة في قول ورقة؟ و قال تعالى:( قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي ) فهل بصيرتهصلىاللهعليهوآلهوسلم هي سكون نفسه إلى قول ورقة؟ و بصيرة من اتّبعه سكون أنفسهم إلى سكون نفسه إلى ما لا حجّة فيه قاطعة؟ و قال تعالى:( إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلى نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ) النساء: 163 فهل كان اعتمادهم في نبوّتهم على مثل ما تقصّه هذه القصّة؟
و الحقّ أنّ وحي النبوّة و الرسالة يلازم اليقين من النبيّ و الرسول بكونه من الله تعالى على ما ورد عن أئمّة أهل البيتعليهمالسلام .
و في المجمع: في قوله:( أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى ) الآية إنّ أبا جهل قال: هل يعفر محمّد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم. قال: فبالّذي يحلف به لئن رأيته يفعل ذلك لأطأنّ رقبته فقيل له: ها هو ذلك يصلّي فانطلق ليطأ على رقبته فما فجأهم إلّا و هو ينكص على عقبيه و يتّقي بيديه فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: إنّ بيني و بينه خندقاً من نار و هؤلاء أجنحة، و قال نبيّ الله: و الّذي نفسي بيده لو دنا منّي لاختطفته الملائكة عضواً عضواً فأنزل الله( أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى ) إلى آخر السورة. رواه مسلم في الصحيح.
و في تفسير القمّيّ: في الآية: كان الوليد بن المغيرة ينهى الناس عن الصلاة و أن يطاع الله و رسوله فقال الله:( أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى عَبْداً إِذا صَلَّى ) .
أقول: مفاده لا يلائم ظهور سياق الآيات في كون المصلّي هو النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم .
و في المجمع، في الحديث عن عبدالله بن مسعود أنّ رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: أقرب ما يكون العبد من الله إذا كان ساجداً.
و في الكافي، بإسناده إلى الوشّاء قال: سمعت الرضاعليهالسلام يقول: أقرب ما يكون العبد من الله و هو ساجد و ذلك قوله:( وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ ) .
و في المجمع، روى عبدالله بن سنان عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: العزائم الم التنزيل و حم السجدة و النجم إذا هوى و اقرأ باسم ربّك، و ما عداها في جميع القرآن مسنون و ليس بمفروض.
( سورة القدر مكّيّة و هي خمس آيات)
( سورة القدر الآيات 1 - 5)
بِّسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ( 1 ) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ( 2 ) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ( 3 ) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ( 4 ) سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ( 5 )
( بيان)
تذكر السورة إنزال القرآن في ليلة القدر و تعظّم الليلة بتفضيلها على ألف شهر و تنزّل الملائكة و الروح فيها، و السورة تحتمل المكّيّة و المدنيّة و لا يخلو بعض(1) ما روي في سبب نزولها عن أئمّة أهل البيتعليهمالسلام و غيرهم من تأييد لكونها مدنيّة.
قوله تعالى: ( إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) ضمير( أَنْزَلْناهُ ) للقرآن و ظاهره جملة الكتاب العزيز لا بعض آياته و يؤيّده التعبير بالإنزال الظاهر في اعتبار الدفعة دون التنزيل الظاهر في التدريج.
و في معنى الآية قوله تعالى:( وَ الْكِتابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ ) الدخان: 3 و ظاهره الإقسام بجملة الكتاب المبين ثمّ الإخبار عن إنزال ما اُقسم به جملة.
فمدلول الآيات أنّ للقرآن نزولاً جملياً على النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم غير نزوله التدريجيّ الّذي تمّ في مدّة ثلاث و عشرين سنة كما يشير إليه قوله:( وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ
____________________
(1) و هو ما دلّ على أنّ السورة بعد رؤيا النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم أنّ بني اُميّة يصعدون منبره فاغتم فسلاه الله بها.
عَلَى النَّاسِ عَلى مُكْثٍ وَ نَزَّلْناهُ تَنْزِيلًا ) إسراء: 106 و قوله:( وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَ رَتَّلْناهُ تَرْتِيلًا ) الفرقان: 32.
فلا يعبأ بما قيل: إنّ معنى قوله:( أَنْزَلْناهُ ) ابتدأنا بإنزاله و المراد إنزال بعض القرآن.
و ليس في كلامه تعالى ما يبيّن أنّ الليلة أيّة ليلة هي غير ما في قوله تعالى:( شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ) البقرة: 185 فإنّ الآية بانضمامها إلى آية القدر تدلّ على أنّ الليلة من ليالي شهر رمضان. و أمّا تعيينها أزيد من ذلك فمستفاد من الأخبار و سيجيء بعض ما يتعلّق به في البحث الروائيّ التالي إن شاء الله.
و قد سمّاها الله تعالى ليلة القدر، و الظاهر أنّ المراد بالقدر التقدير فهي ليلة التقدير يقدّر الله فيها حوادث السنة من الليلة إلى مثلها من قابل من حياة و موت و رزق و سعادة و شقاء و غير ذلك كما يدلّ عليه قوله في سورة الدخان في صفة الليلة:( فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْراً مِنْ عِنْدِنا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ) الدخان: 6 فليس فرق الأمر الحكيم إلّا أحكام الحادثة الواقعة بخصوصياتها بالتقدير.
و يستفاد من ذلك أنّ الليلة متكرّرة بتكرّر السنين ففي شهر رمضان من كلّ سنة قمريّة ليلة تقدّر فيها اُمور السنة من الليلة إلى مثلها من قابل إذ لا معنى لفرض ليلة واحدة بعينها أو ليال معدودة في طول الزمان تقدّر فيها الحوادث الواقعة الّتي قبلها و الّتي بعدها و إن صحّ فرض واحدة من ليالي القدر المتكرّرة ينزل فيها القرآن جملة واحدة.
على أنّ قوله:( يُفْرَقُ ) - و هو فعل مضارع - ظاهر في الاستمرار، و قوله:( خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ) و( تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ ) إلخ يؤيّد ذلك.
فلا وجه لما قيل: إنّها كانت ليلة واحدة بعينها نزل فيها القرآن من غير أن يتكرّر، و كذا ما قيل: إنّها كانت تتكرّر بتكرّر السنين في زمن النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم ثمّ رفعها الله، و كذا ما قيل: إنّها واحدة بعينها في جميع السنة و كذا ما قيل: إنّها في
جميع السنة غير أنّها تتبدّل بتكرّر السنين فسنة في شهر رمضان و سنة في شعبان و سنة في غيرهما.
و قيل: القدر بمعنى المنزلة و إنّما سمّيت ليلة القدر للاهتمام بمنزلتها أو منزلة المتعبّدين فيها، و قيل: القدر بمعنى الضيق و سمّيت ليلة القدر لضيق الأرض فيها بنزول الملائكة. و الوجهان كما ترى.
فمحصّل الآيات - كما ترى - أنّها ليلة بعينها من شهر رمضان من كلّ سنة فيها أحكام الاُمور بحسب التقدير، و لا ينافي ذلك وقوع التغيّر فيها بحسب التحقّق في ظرف السنة فإنّ التغيّر في كيفيّة تحقّق المقدّر أمر و التغيّر في التقدير أمر آخر كما أنّ إمكان التغيّر في الحوادث الكونيّة بحسب المشيّة الإلهيّة لا ينافي تعيّنها في اللوح المحفوظ قال تعالى:( وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ ) الرعد: 39.
على أنّ لاستحكام الاُمور بحسب تحقّقها مراتب من حيث حضور أسبابها و شرائطها تامّة و ناقصة و من المحتمل أن تقع في ليلة القدر بعض مراتب الإحكام و يتأخّر تمام الإحكام إلى وقت آخر لكنّ الروايات كما ستأتي لا تلائم هذا الوجه.
قوله تعالى: ( وَ ما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ ) كناية عن جلالة قدر الليلة و عظم منزلتها و يؤكّد ذلك إظهار الاسم مرّة بعد مرّة حيث قيل:( ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ ) و لم يقل: و ما أدراك ما هي هي خير.
قوله تعالى: ( لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ) بيان إجماليّ لما اُشير إليه بقوله:( وَ ما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ ) من فخامة أمر الليلة.
و المراد بكونها خيراً من ألف شهر خيريّتها منها من حيث فضيلة العبادة على ما فسّره المفسّرون و هو المناسب لغرض القرآن و عنايته بتقريب الناس إلى الله فإحياؤها بالعبادة خير من عبادة ألف شهر، و يمكن أن يستفاد ذلك من المباركة المذكورة في سورة الدخان في قوله:( إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ ) و هناك معنى آخر سيأتي في البحث الروائي التالي إن شاء الله.
قوله تعالى: ( تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ) تنزّل
أصله تتنزّل، و الظاهر من الروح هو الروح الّذي من الأمر قال تعالى:( قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ) إسراء: 85 و الإذن في الشيء الرخصة فيه و هو إعلام عدم المانع منه.
و( مِنْ ) في قوله:( مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ) قيل: بمعنى الباء و قيل: لابتداء الغاية و تفيد السببيّة أي بسبب كلّ أمر إلهي، و قيل: للتعليل بالغاية أي لأجل تدبير كلّ أمر من الاُمور و الحقّ أنّ المراد بالأمر إن كان هو الأمر الإلهيّ المفسّر بقوله( إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ ) يس: 82 فمن للابتلاء و تفيد السببيّة و المعنى تتنزّل الملائكة و الروح في ليلة القدر بإذن ربّهم مبتدأ تنزّلهم و صادراً من كلّ أمر إلهيّ.
و إن كان هو الأمر من الاُمور الكونيّة و الحوادث الواقعة فمن بمعنى اللّام التعليليّة و المعنى تتنزّل الملائكة و الروح في الليلة بإذن ربّهم لأجل تدبير كلّ أمر من الاُمور الكونيّة.
قوله تعالى: ( سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ) قال في المفردات: السلام و السلامة التعرّي من الآفات الظاهرة و الباطنة انتهى فيكون قوله:( سَلامٌ هِيَ ) إشارة إلى العناية الإلهيّة بشمول الرحمة لعباده المقبلين إليه و سدّ باب نقمة جديدة تختصّ بالليلة و يلزمه بالطبع وهن كيد الشياطين كما اُشير إليه في بعض الروايات.
و قيل: المراد به أنّ الملائكة يسلّمون على من مرّوا به من المؤمنين المتعبّدين و مرجعه إلى ما تقدّم.
و الآيتان أعني قوله:( تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ ) إلى آخر السورة في معنى التفسير لقوله:( لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ) .
( بحث روائي)
في تفسير البرهان، عن الشيخ الطوسيّ عن أبي ذرّ قال: قلت يا رسول الله ليلة القدر شيء يكون على عهد الأنبياء ينزل عليهم فيها الأمر فإذا مضوا رفعت؟ قال: لا بل هي إلى يوم القيامة.
أقول: و في معناه غير واحد من الروايات من طرق أهل السنّة.
و في المجمع، و عن حمّاد بن عثمان عن حسّان بن أبي عليّ قال: سألت أباعبداللهعليهالسلام عن ليلة القدر قال: اطلبها في تسع عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين.
أقول: و في معناه غيرها، و في بعض الأخبار الترديد بين ليلتين الإحدى و العشرين و الثلاث و العشرين كرواية العيّاشيّ عن عبد الواحد عن الباقرعليهالسلام و يستفاد من روايات أنّها ليلة ثلاث و عشرين و إنّما لم يعيّن تعظيماً لأمرها أن لا يستهان بها بارتكاب المعاصي.
و فيه، أيضاً في رواية عبدالله بن بكير عن زرارة عن أحدهماعليهماالسلام قال: ليلة ثلاث و عشرين هي ليلة الجهنيّ، و حديثه أنّه قال لرسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم . إنّ منزلي نائي عن المدينة فمرني بليلة أدخل فيها فأمره بليلة ثلاث و عشرين.
أقول: و حديث الجهنيّ و اسمه عبدالله بن أنيس الأنصاريّ مرويّ من طرق أهل السنّة أيضاً أورده في الدرّ المنثور، عن مالك و البيهقيّ.
و في الكافي، بإسناده عن زرارة قال: قال أبوعبداللهعليهالسلام : التقدير في تسع عشرة، و الإبرام في ليلة إحدى و عشرين، و الإمضاء في ليلة ثلاث و عشرين.
أقول: و في معناها روايات اُخر.
فقد اتّفقت أخبار أهل البيتعليهمالسلام أنّها باقية متكرّرة كلّ سنة، و أنّها ليلة من ليالي شهر رمضان و أنّها إحدى الليالي الثلاث.
و أمّا من طرق أهل السنّة فقد اختلفت الروايات اختلافاً عجيباً يكاد لا يضبط
و المعروف عندهم أنّها ليلة سبع و عشرون فيها نزل القرآن، و من أراد الحصول عليها فليراجع الدرّ المنثور و سائر الجوامع.
و في الدرّ المنثور، أخرج الخطيب عن ابن المسيّب قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : اُريت بني اُميّة يصعدون منبري فشقّ ذلك عليّ فأنزل الله إنّا أنزلناه في ليلة القدر.
أقول: و روي أيضاً مثله عن الخطيب في تاريخه، عن ابن عبّاس، و أيضاً ما في معناه عن الترمذيّ و ابن جرير و الطبرانيّ و ابن مردويه و البيهقيّ عن الحسن بن عليّ و هناك روايات كثيرة في هذا المعنى من طرق الشيعة عن أئمّة أهل البيتعليهمالسلام و فيها أنّ الله تعالى سلّى نبيّهصلىاللهعليهوآلهوسلم بإعطاء ليلة القدر و جعلها خيراً من ألف شهر و هي مدّة ملك بني اُميّة.
و في الكافي، بإسناده عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبداللهعليهالسلام قال له بعض أصحابنا و لا أعلمه إلّا سعيد السمّان: كيف تكون ليلة القدر خيراً من ألف شهر؟ قال: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر.
و فيه، بإسناده عن الفضيل و زرارة و محمّد بن مسلم عن حمران أنّه سأل أبا جعفرعليهالسلام عن قول الله عزّوجلّ:( إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ ) قال: نعم ليلة القدر و هي في كلّ سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر فلم ينزل القرآن إلّا في ليلة القدر قال الله عزّوجلّ:( فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ) .
قال: يقدّر في ليلة القدر كلّ شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل: خير و شرّ طاعة و معصية و مولود و أجل أو رزق فما قدّر في تلك الليلة و قضي فهو المحتوم و لله عزّوجلّ فيه المشيّة.
قال: قلت:( لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ) أيّ شيء عنى بذلك؟ فقال: و العمل الصالح فيها من الصلاة و الزكاة و أنواع الخير خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، و لو لا ما يضاعف الله تبارك و تعالى للمؤمنين ما بلغوا و لكنّ الله يضاعف لهم الحسنات.
أقول: و قوله: و لله فيه المشيّة يريد به إطلاق قدرته تعالى فله أن يشاء ما يشاء
و إن حتم فإنّ إيجابه الأمر لا يقيّد القدرة المطلقة فله أن ينقض القضاء المحتوم و إن كان لا يشاء ذلك أبداً.
و في المجمع، روى ابن عبّاس عن النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال: إذا كان ليلة القدر تنزّل الملائكة الّذين هم سكّان سدرة المنتهى و منهم جبرائيل فينزل جبرائيل و معه ألوية ينصب لواء منها على قبري و لواء على بيت المقدس و لواء في المسجد الحرام و لواء على طور سيناء و لا يدع فيها مؤمناً و لا مؤمنة إلّا سلّم عليه إلّا مدمن خمر و آكل لحم الخنزير(1) و المتضمّخ بالزعفران.
و في تفسير البرهان، عن سعد بن عبدالله بإسناده عن أبي بصير قال: كنت مع أبي عبداللهعليهالسلام فذكر شيئاً من أمر الإمام إذا ولد فقال: استوجب زيادة الروح في ليلة القدر فقلت: جعلت فداك أ ليس الروح هو جبرئيل؟ فقال: جبرئيل من الملائكة و الروح أعظم من الملائكة أ ليس أنّ الله عزّوجلّ يقول:( تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ ) .
أقول: و الروايات في ليلة القدر و فضلها كثيرة جدّاً، و قد ذكرت في بعضها لها علامات ليست بدائمة و لا أكثريّة كطلوع الشمس صبيحتها و لا شعاع لها و اعتدال الهواء فيها أغمضنا عنها.
____________________
(1) تضمّخ بالطيب تلطخ به.
( سورة البيّنة مدنيّة و هي ثمان آيات)
( سورة البيّنة الآيات 1 - 8)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ( 1 ) رَسُولٌ مِّنَ اللهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ( 2 ) فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ( 3 ) وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ( 4 ) وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ( 5 ) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ( 6 ) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ( 7 ) جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ( 8 )
( بيان)
تسجّل السورة رسالة محمّدصلىاللهعليهوآلهوسلم لعامّة أهل الكتاب و المشركين و بعبارة اُخرى للملّيّين و غيرهم و هم عامّة البشر فتفيد عموم الرسالة و أنّها ممّا كانت تقتضيه السنّة الإلهيّة - سنّة الهداية - الّتي تشير إليها أمثال قوله تعالى:( إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً ) الإنسان: 3، و قوله:( وَ إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِيها نَذِيرٌ )
فاطر: 24، و تحتجّ على عموم دعوتهصلىاللهعليهوآلهوسلم بأنّها لا تتضمّن إلّا ما يصلح المجتمع الإنسانيّ من الاعتقاد و العمل على ما سيتّضح إن شاء الله.
و السورة تحتمل المكّيّة و المدنيّة و إن كان سياقها بالمدنيّة أشبه.
قوله تعالى: ( لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ الْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ) ظاهر الآيات - و هي في سياق يشير إلى قيام الحجّة على الّذين كفروا بالدعوة الإسلاميّة من أهل الكتاب و المشركين و على الّذين اُوتوا الكتاب حينما بدا فيهم الاختلاف - أنّ المراد هو الإشارة إلى أنّ الرسولصلىاللهعليهوآلهوسلم من مصاديق الحجّة البيّنة القائمة على الناس الّتي تقتضي قيامها السنّة الإلهيّة الجارية في عباده فقد كانت توجب مجيء البيّنة إليهم كما أوجبته من قبل ما تفرّقوا في دينهم.
و على هذا فالمراد بالّذين كفروا في الآية هم الكافرون بالدعوة النبويّة الإسلاميّة من أهل الكتاب و المشركين، و( مِنْ ) في قوله:( مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ ) للتبعيض لا للتبيين، و قوله: و( الْمُشْرِكِينَ ) عطف على( أَهْلِ الْكِتابِ ) و المراد بهم غير أهل الكتاب من عبدة الأصنام و غيرهم.
و قوله:( مُنْفَكِّينَ ) من الانفكاك و هو الانفصال عن شدّة اتّصال، و المراد به - على ما يستفاد من قوله:( حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ) - انفكاكهم عمّا تقتضي سنّة الهداية و البيان كأنّ السنّة الإلهيّة كانت قد أخذتهم و لم تكن تتركهم حتّى تأتيهم البيّنة و لما أتتهم البيّنة تركتهم و شأنهم كما قال تعالى:( وَ ما كانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ ) التوبة: 115.
و قوله:( حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ) على ظاهره من الاستقبال و البيّنة هي الحجّة الظاهرة و المعنى لم يكن الّذين كفروا برسالة النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم أو بدعوته أو بالقرآن لينفكّوا حتّى تأتيهم البيّنة و البيّنة هي محمّدصلىاللهعليهوآلهوسلم .
و للقوم اختلاف عجيب في تفسير الآية و معاني مفرداتها حتّى قال بعضهم - على ما نقل -: إنّ الآية من أصعب الآيات القرآنيّة نظماً و تفسيراً. انتهى، و الّذي أوردناه من المعنى هو الّذي يلائمه سياقها من غير تناقض بين الآيات و تدافع بين
الجمل و المفردات، و من أراد الاطّلاع على تفصيل ما قيل و يقال فعليه أن يراجع المطوّلات.
قوله تعالى: ( رَسُولٌ مِنَ اللهِ يَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً فِيها كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ) بيان للبيّنة و المراد به محمّد رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم قطعاً على ما يعطيه السياق.
و الصحف جمع صحيفة و هي ما يكتب فيها، و المراد بها أجزاء القرآن النازلة و قد تكرّر في كلامه تعالى إطلاق الصحف على أجزاء الكتب السماويّة و منها القرآن الكريم قال تعالى:( فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرامٍ بَرَرَةٍ ) عبس: 16.
و المراد بكون الصحف مطهّرة تقدّسها من قذارة الباطل بمسّ الشياطين، و قد تكرّر منه تعالى أنّه حقّ مصون من مداخلة الشياطين و قال:( لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) الواقعة: 79.
و قوله:( فِيها كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ) الكتب جمع كتاب و معناه المكتوب و يطلق على اللوح و القرطاس و نحوهما المنقوشة فيها الألفاظ و على نفس الألفاظ الّتي تحكي عنها النقوش، و ربّما يطلق على المعاني بما أنّها محكيّة بالألفاظ، و يطلق أيضاً على الحكم و القضاء يقال كتب عليه كذا أي قضى أن يفعل كذا قال تعالى:( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ ) البقرة: 183 و قال:( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ ) البقرة: 216.
و الظاهر أنّ المراد بالكتب الّتي في الصحف الأحكام و القضايا الإلهيّة المتعلّقة بالاعتقاد و العمل، و من الدليل عليه توصيفها بالقيّمة فإنّها من القيام بالشيء بمعنى حفظه و مراعاة مصلحته و ضمان سعادته قال تعالى:( أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ) يوسف: 40، و معلوم أنّ الصحف السماويّة إنّما تقوم بأمر المجتمع الإنسانيّ و تحفظ مصلحته بما فيها من الأحكام و القضايا المتعلّقة بالاعتقاد و العمل.
فمعنى الآيتين: الحجّة البيّنة الّتي أتتهم رسول من الله يقرأ صحائف سماويّة مطهّرة من دنس الباطل في تلك الصحائف أحكام و قضايا قائمة بأمر المجتمع الإنسانيّ حافظة لمصالحه.
قوله تعالى: ( وَ ما تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ) كانت الآية الاُولى( لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ ) إلخ تشير إلى كفرهم بالنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم و كتابه المتضمّن للدعوة الحقّة و هذه الآية تشير إلى اختلافهم السابق على الدعوة الإسلاميّة و قد اُشير إلى ذلك في مواضع من القرآن الكريم كما قال تعالى:( وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ ) آل عمران: 19 إلى غير ذلك من الآيات.
و مجيء البيّنة لهم هو البيان النبويّ الّذي تبيّن لهم في كتابهم أو أوضحه لهم أنبياؤهم قال تعالى:( وَ لَمَّا جاءَ عِيسى بِالْبَيِّناتِ قالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَ لِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللهَ وَ أَطِيعُونِ إِنَّ اللهَ هُوَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ) الزخرف: 65.
فإن قلت: ما باله تعرّض لاختلاف أهل الكتاب و تفرّقهم في مذاهبهم و لم يتعرّض لتفرّق المشركين و إعراضهم عن دين التوحيد و إنكارهم الرسالة.
قلت: لا يبعد أن يكون قوله:( وَ ما تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ) إلخ شاملاً للمشركين كما هو شامل لأهل الكتاب فقد بدّل أهل الكتاب - و هم في عرف القرآن اليهود و النصارى و الصابئون و المجوس أو اليهود و النصارى - من الّذين اُوتوا الكتاب، و التعبيران متغايران، و قد صرّح تعالى بأنّه أنزل الكتاب - و هو الشريعة المفروضة عليهم الحاكمة في اختلافاتهم في اُمور الحياة - أوّل ما بدا الاختلافات الحيويّة بينهم ثمّ اختلفوا في الدين بعد تبيّن الحقّ لهم و قيام الحجّة عليهم فعامّة البشر آتاهم الله كتاباً ثمّ اختلفوا فيه فمنهم من نسي ما اُوتيه، و منهم من أخذ به محرّفاً و منهم من حفظه و آمن به، قال تعالى:( كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ ) البقرة: 213 و قد مرّ تفسير الآية.
و في هذا المعنى قوله تعالى:( تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ - إلى أن
قال -وَ لَوْ شاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ وَ لكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ) البقرة: 253.
و بالجملة فالّذين اُوتوا الكتاب أعمّ من أهل الكتاب فقوله:( وَ ما تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ) إلخ يشمل المشركين كما يشمل أهل الكتاب.
قوله تعالى: ( وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ ) إلخ ضمير( أُمِرُوا ) للّذين كفروا من أهل الكتاب و المشركين أي لم يتضمّن رسالة الرسولصلىاللهعليهوآلهوسلم و الكتب القيّمة الّتي في صحف الوحي إلّا أمرهم بعبادة الله تعالى بقيد الإخلاص في الدين فلا يشركوا به شيئاً.
و قوله:( حُنَفاءَ ) حال من ضمير الجمع و هو جمع حنيف من الحنف و هو الميل عن جانبي الإفراط و التفريط إلى حاقّ وسط الاعتدال و قد سمّى الله تعالى الإسلام ديناً حنيفاً لأنّه يأمر في جميع الاُمور بلزوم الاعتدال و التحرّز عن الإفراط و تفريط.
و قوله:( وَ يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكاةَ) من قبيل ذكر الخاصّ بعد العامّ أو الجزء بعد الكلّ اهتماماً بأمره فالصلاة و الزكاة على أركان الإسلام و هما التوجّه العبوديّ الخاصّ إلى الله و إنفاق المال في الله.
و قوله:( وَ ذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ) أي دين الكتب القيّمة على ما فسّروا، و المراد بالكتب القيّمة إن كان جميع الكتب السماويّة أعني كتاب نوح و من دونه من الأنبياءعليهمالسلام فالمعنى أنّ هذا الّذي اُمروا به و دعوا إليه في الدعوة المحمّديّة هو الدين الّذي كلّفوا به في كتبهم القيّمة و ليس بأمر بدع فدين الله واحد و عليهم أن يدينوا به لأنّه القيّم.
و إن كان المراد به ما كان يتلوه النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم من الكتب القيّمة الّتي في الصحف المطهّرة فالمعنى أنّهم لم يؤمروا في الدعوة الإسلاميّة إلّا بأحكام و قضايا هي القيّمة الحافظة لمصالح المجتمع الإنسانيّ فلا يسعهم إلّا أن يؤمنوا بها و يتديّنوا.
فالآية على أيّ حال تشير إلى كون دين التوحيد الّذي يتضمّنه القرآن
الكريم المصدّق لما بين يديه من الكتاب و المهيمن(1) عليه فيما يأمر المجتمع البشري قائماً بأمرهم حافظاً لمصالح حياتهم كما يبيّنه بأوفى البيان قوله تعالى:( فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ) الروم: 30.
و بهذه الآية يكمل بيان عموم رسالة النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم و شمول الدعوة الإسلاميّة لعامّة البشر فقوله:( لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ الْمُشْرِكِينَ ) إلخ يشير إلى أنّه كان من الواجب في سنّة الهداية الإلهيّة أن تتمّ الحجّة على من كفر بالدعوة من أهل الكتاب و المشركين، و هؤلاء و إن كانوا بعض أهل الكتاب و المشركين لكن من الضروريّ أن لا فرق بين البعض و البعض في تعلّق الدعوة فتعلّقها بالبعض لا ينفكّ عن تعلّقها بالكلّ.
و قوله:( رَسُولٌ مِنَ اللهِ ) إلخ يشير إلى أنّ تلك البيّنة محمّدصلىاللهعليهوآلهوسلم ، و قوله:( وَ ما تَفَرَّقَ ) إلخ يشير إلى أنّ تفرّقهم و كفرهم السابق بالحقّ أيضاً كان بعد مجيء البيّنة.
و قوله:( وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ ) إلخ يفيد أنّ الّذي دعوا إليه و اُمروا به دين قيّم حافظ لمصالح المجتمع البشريّ فعليهم جميعاً أن يؤمنوا به و لا يكفروا.
قوله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ الْمُشْرِكِينَ فِي نارِ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أُولئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ) لمّا فرغ من الإشارة إلى كفرهم بالبيّنة الّتي كانت توجبها سنّة الهداية الإلهيّة و ما كانت تدعو إليه من الدين القيّم أخذ في الإنذار و التبشير بوعيد الكفّار و وعد المؤمنين، و البريّة الخلق، و المعنى ظاهر.
قوله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ) فيه قصر الخيريّة في المؤمنين الصالحين كما أنّ في الآية السابقة قصر الشرّيّة في الكفّار.
____________________
(1) سورة المائدة، آية 48.
قوله تعالى: ( جَزاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ - إلى قوله -ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ) العدن الاستقرار و الثبات فجنّات عدن جنّات خلود و دوام و توصيفها بقوله:( خالِدِينَ فِيها أَبَداً ) تأكيد بما يدلّ عليه الاسم.
و قوله:( رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ) الرضى منه تعالى صفة فعل و مصداقه الثواب الّذي أعطاهموه جزاء لإيمانهم و عملهم الصالح.
و قوله:( ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ) علامة مضروبة لسعادة الدار الآخرة و قد قال تعالى:( إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ ) فاطر: 28 فالعلم بالله يستتبع الخشية منه، و الخشية منه تستتبع الإيمان به بمعنى الالتزام القلبي بربوبيّته و اُلوهيّته ثمّ العمل الصالح.
و اعلم أنّ لهم في تفسير مفردات هذه الآيات اختلافاً شديداً و أقوالاً كثيرة لا جدوى في التعرّض لها من أراد الوقوف عليها فليراجع المطوّلات.
( بحث روائي)
في تفسير القمّيّ، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرعليهالسلام قال: البيّنة محمّد رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم .
و في الدرّ المنثور، أخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله من أكرم الخلق على الله؟ قال: يا عائشة أ ما تقرئين( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ) ؟
و فيه، أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبدالله قال: كنّا عند النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم فأقبل عليّ فقال النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم : و الّذي نفسي بيده إنّ هذا و شيعته لهم الفائزون يوم القيامة و نزلت:( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ) فكان أصحاب النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم إذا أقبل عليّ قالوا: جاء خير البريّة.
أقول: و روي هذا المعنى أيضاً عن ابن عديّ عن ابن عبّاس، و أيضاً عن ابن
مردويه عن عليّعليهالسلام و رواه أيضاً في البرهان، عن الموفّق بن أحمد في كتاب المناقب عن يزيد بن شراحيل الأنصاريّ كاتب عليّ عنه، و كذا في المجمع، عن كتاب شواهد التنزيل للحاكم عن يزيد بن شراحيل عنه، و لفظه: سمعت عليّا يقول: قبض رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم و أنا مسنده إلى صدري فقال: يا عليّ أ لم تسمع قول الله:( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ) هم شيعتك و موعدي و موعدكم الحوض إذا اجتمع الاُمم للحساب يدعون غرّاً محجّلين.
و في المجمع، عن مقاتل بن سليمان عن الضحّاك عن ابن عبّاس في قوله:( هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ) قال: نزلت في عليّ و أهل بيته.
( سورة الزلزال مدنيّة و هي ثمان آيات)
( سورة الزلزلة الآيات 1 - 8)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ( 1 ) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ( 2 ) وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا ( 3 ) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ( 4 ) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ( 5 ) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ( 6 ) فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ( 7 ) وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ( 8 )
( بيان)
ذكر للقيامة و صدور الناس للجزاء و إشارة إلى بعض أشراطها و هي زلزلة الأرض و تحديثها أخبارها. و السورة تحتمل المكّيّة و المدنيّة.
قوله تعالى: ( إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها ) الزلزال مصدر كالزلزلة، و إضافته إلى ضمير الأرض تفيد الاختصاص، و المعنى إذا زلزلت الأرض زلزلتها الخاصّة بها فتفيد التعظيم و التفخيم أي إنّها منتهية في الشدّة و الهول.
قوله تعالى: ( وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها ) الأثقال جمع ثقل بفتحتين بمعنى المتاع أو خصوص متاع المسافر أو جمع ثقل بالكسر فالسكون بمعنى الحمل، و على أيّ حال المراد بأثقالها الّتي تخرجها، الموتى على ما قيل أو الكنوز و المعادن الّتي في بطنها أو الجميع و لكلّ قائل و أوّل الوجوه أقربها ثمّ الثالث لتكون الآية إشارة إلى خروجهم للحساب، و قوله:( يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ ) إشارة إلى انصرافهم إلى الجزاء.
قوله تعالى: ( وَ قالَ الْإِنْسانُ ما لَها ) أي يقول مدهوشاً متعجّباً من تلك الزلزلة الشديدة الهائلة: ما للأرض تتزلزل هذا الزلزال، و قيل: المراد بالإنسان الكافر غير
المؤمن بالبعث، و قيل غير ذلك كما سيجيء.
قوله تعالى: ( يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها ) فتشهد على أعمال بني آدم كما تشهد بها أعضاؤهم و كتاب الأعمال من الملائكة و شهداء الأعمال من البشر و غيرهم.
و قوله:( بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها ) اللّام بمعنى إلى لأنّ الإيحاء يتعدّى بإلى و المعنى تحدّث أخبارها بسبب أنّ ربّك أوحى إليها أن تحدّث فهي شاعرة بما يقع فيها من الأعمال خيرها و شرّها متحمّلة لها يؤذن لها يوم القيامة بالوحي أن تحدّث أخبارها و تشهد بما تحمّلت، و قد تقدّم في تفسير قوله تعالى:( وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ) إسراء: 44، و قوله:( قالُوا أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ) حم السجدة: 21 أنّ المستفاد من كلامه سبحانه أنّ الحياة و الشعور ساريان في الأشياء و إن كنّا في غفلة من ذلك.
و قد اشتدّ الخلاف بينهم في معنى تحديث الأرض بالوحي أ هو بإعطاء الحياة و الشعور للأرض الميتة حتّى تخبر بما وقع فيها أو بخلق صوت عندها و عدّ ذلك تكلّماً منها أو دلالتها بلسان الحال بما وقع فيها من الأعمال، و لا محلّ لهذا الاختلاف بعد ما سمعت و لا أنّ الحجّة تتمّ على أحد بهذا النوع من الشهادة.
قوله تعالى: ( يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتاتاً لِيُرَوْا أَعْمالَهُمْ ) الصدور انصراف الإبل عن الماء بعد وروده، و أشتات كشتّى جمع شتيت بمعنى المتفرّق، و الآية جواب بعد جواب لإذا.
و المراد بصدور الناس متفرّقين يومئذ انصرافهم عن الموقف إلى منازلهم في الجنّة و النار و أهل السعادة و الفلاح منهم متميّزون من أهل الشقاء و الهلاك، و إراءتهم أعمالهم إراءتهم جزاء أعمالهم بالحلول فيه أو مشاهدتهم نفس أعمالهم بناء على تجسّم الأعمال.
و قيل: المراد به خروجهم من قبورهم إلى الموقف متفرّقين متميّزين بسواد الوجوه و بياضها و بالفزع و الأمن و غير ذلك لإعلامهم جزاء أعمالهم بالحساب و التعبير
عن العلم بالجزاء بالرؤية و عن الاعلام بالإراءة نظير ما في قوله تعالى:( يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ ) آل عمران: 30، و الوجه الأوّل أقرب و أوضح.
قوله تعالى: ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ) المثقال ما يوزن به الأثقال، و الذرّة ما يرى في شعاع الشمس من الهباء، و تقال لصغار النمل.
تفريع على ما تقدّم من إراءتهم أعمالهم، فيه تأكيد البيان في أنّه لا يستثني من الإراءة عمل خيراً أو شرّاً كبيراً أو صغيراً حتّى مثقال الذرّة من خير أو شرّ، و بيان حال كلّ من عمل الخير و الشرّ في جملة مستقلّة لغرض إعطاء الضابط و ضرب القاعدة.
و لا منافاة بين ما تدلّ عليه الآيتان من العموم و بين الآيات الدالّة على حبط الأعمال، و الدالّة على انتقال أعمال الخير و الشرّ من نفس إلى نفس كحسنات القاتل إلى المقتول و سيّئات المقتول إلى القاتل، و الدالّة على تبديل السيّئات حسنات في بعض التائبين إلى غير ذلك ممّا تقدّمت الإشارة إليه في بحث الأعمال في الجزء الثاني من الكتاب و كذا في تفسير قوله:( لِيَمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ) الآية: الأنفال: 37.
و ذلك لأنّ الآيات المذكورة حاكمة على هاتين الآيتين فإنّ من حبط عمله الخير محكوم بأنّه لم يعمل خيراً فلا عمل له خيراً حتّى يراه و على هذا القياس في غيره فافهم.
( بحث روائي)
في الدرّ المنثور، أخرج ابن مردويه و البيهقيّ في شعب الإيمان عن أنس بن مالك أنّ رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: إنّ الأرض لتخبر يوم القيامة بكلّ ما عمل على ظهرها و قرأ رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ( إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها ) حتّى بلغ( يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها ) قال أ تدرون ما أخبارها؟ جاءني جبريل قال: خبرها إذا كان يوم القيامة أخبرت بكلّ عمل عمل على ظهرها.
أقول: و روي مثله عن أبي هريرة.
و فيه، أخرج الحسين بن سفيان في مسنده و أبو نعيم في الحلية عن شدّاد بن أوس قال: سمعت رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم يقول:
أيّها الناس إنّ الدنيا عرض حاضر يأكل منه البرّ و الفاجر، و إنّ الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادر يحقّ فيها الحقّ و يبطل الباطل.
أيّها الناس كونوا من أبناء الآخرة و لا تكونوا من أبناء الدنيا فإنّ كلّ اُمّ يتبعها ولدها اعملوا و أنتم من الله على حذر، و اعلموا أنّكم معروضون على أعمالكم و أنّكم ملاقوا الله لا بدّ منه فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره و من يعمل مثقال ذرّة شرّاً يره.
و في تفسير القمّيّ: في قوله تعالى:( وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها ) قال: من الناس( وَ قالَ الْإِنْسانُ ما لَها ) قال: ذلك أميرالمؤمنينعليهالسلام ( يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها - إلى قوله -أَشْتاتاً ) قال: يجيئون أشتاتاً مؤمنين و كافرين و منافقين( لِيُرَوْا أَعْمالَهُمْ ) قال: يقفون على ما فعلوه.
و فيه، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرعليهالسلام : في قوله:( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ) يقول: إن كان من أهل النار قد عمل مثقال ذرّة في الدنيا خيراً (كان عليه ظ) يوم القيامة حسرة إن كان عمله لغير الله( وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ) يقول: إن كان من أهل الجنّة راى ذلك الشرّ يوم القيامة ثمّ غفر له.
( سورة العاديات مدنيّة و هي إحدى عشرة آية)
( سورة العاديات الآيات 1 - 11)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ( 1 ) فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ( 2 ) فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ( 3 ) فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ( 4 ) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ( 5 ) إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ( 6 ) وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ( 7 ) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ( 8 ) أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ( 9 ) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ( 10 ) إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ( 11 )
( بيان)
تذكر السورة كفران الإنسان لنعم ربّه و حبّه الشديد للخير عن علم منه به و هو حجّة عليه و سيحاسب على ذلك.
و السورة مدنيّة بشهادة ما في صدرها من الإقسام بمثل قوله:( وَ الْعادِياتِ ضَبْحاً ) إلخ الظاهر في خيل الغزاة المجاهدين على ما سيجيء، و إنّما شرّع الجهاد بعد الهجرة و يؤيّد ذلك ما ورد من طرق الشيعة عن أئمّة أهل البيتعليهمالسلام أنّ السورة نزلت في عليّعليهالسلام و سريّته في غزوة ذات السلاسل، و يؤيّده أيضاً بعض الروايات من طرق أهل السنّة على ما سنشير إليه في البحث الروائيّ التالي إن شاء الله.
قوله تعالى: ( وَ الْعادِياتِ ضَبْحاً ) العاديات من العدو و هو الجري بسرعة و الضبح صوت أنفاس الخيل عند عدوها و هو المعهود المعروف من الخيل و إن ادّعي أنّه يعرض لكثير من الحيوان غيرها، و المعنى اُقسم بالخيل اللّاتي يعدون يضبحن ضبحاً.
و قيل: المراد بها إبل الحاج في ارتفاعها بركبانها من الجمع إلى منى يوم النحر،
و قيل: إبل الغزاة، و ما في الآيات التالية من الصفات لا يلائم كون الإبل هو المراد بالعاديات.
قوله تعالى: ( فَالْمُورِياتِ قَدْحاً ) الإيراء إخراج النار و القدح الضرب و الصكّ المعروف يقال: قدح فأورى إذا أخرج النار بالقدح، و المراد بها الخيل تخرج النار بحوافرها إذا عدت على الحجارة و الأرض المحصبة.
و قيل: المراد بالإيراء مكر الرجال في الحرب، و قيل: إيقادهم النار، و قيل: الموريات ألسنة الرجال توري النار من عظيم ما تتكلّم به، و هي وجوه ظاهرة الضعف.
قوله تعالى: ( فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً ) الإغارة و الغارة الهجوم على العدوّ بغتة بالخيل و هي صفة أصحاب الخيل و نسبتها إلى الخيل مجاز، و المعنى فاُقسم بالخيل الهاجمات على العدوّ بغتة في وقت الصبح.
و قيل: المراد بها الآبال ترتفع بركبانها يوم النحر من جمع إلى منى و السنّة أن لا ترتفع حتّى تصبح، و الإغارة سرعة السير و هو خلاف ظاهر الإغارة.
قوله تعالى: ( فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً ) أثرن من الإثارة بمعنى تهييج الغبار و نحوه، و النقع الغبار، و المعنى فهيّجن بالعدو و الإغارة غباراً.
قيل: لا بأس بعطف( فَأَثَرْنَ ) و هو فعل على ما قبله و هو صفة لأنّه اسم فاعل و هو في معنى الفعل كأنّه قيل: اُقسم باللّاتي عدون فأورين فأغرن فأثرن.
قوله تعالى: ( فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً ) وسط و توسّط بمعنى، و ضمير( بِهِ ) للصبح و الباء بمعنى في أو الضمير للنقع و الباء للملابسة.
و المعنى فصرن في وقت الصبح في وسط جمع و المراد به كتيبة العدوّ أو المعنى فتوسّطن جمعاً ملابسين للنقع.
و قيل: المراد توسّط الآبال جمع منى و أنت خبير بأنّ حمل الآيات الخمس بما لمفرداتها من ظواهر المعاني على إبل الحاج الّذين يفيضون من جمع إلى منى خلاف ظاهرها جدّاً.
فالمتعيّن حملها على خيل الغزاة و سياق الآيات و خاصّة قوله:( فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً ) ( فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً ) يعطي أنّها غزاة بعينها أقسم الله فيها بخيل المجاهدين العاديات و الفاء في الآيات الأربع تدلّ على ترتّب كلّ منها على ما قبلها.
قوله تعالى: ( إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ) الكنود الكفور، و الآية كقوله:( إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ ) الحجّ: 66، و هو إخبار عمّا في طبع الإنسان من اتّباع الهوى و الانكباب على عرض الدنيا و الانقطاع به عن شكر ربّه على ما أنعم عليه.
و فيه تعريض للقوم المغار عليهم، و كأنّ المراد بكفرانهم كفرانهم بنعمة الإسلام الّتي أنعم الله بها عليهم و هي أعظم نعمة اُوتوها فيها طيب حياتهم الدنيا و سعادة حياتهم الأبديّة الاُخرى.
قوله تعالى: ( وَ إِنَّهُ عَلى ذلِكَ لَشَهِيدٌ ) ظاهر اتّساق الضمائر أن يكون ضمير( وَ إِنَّهُ ) للإنسان فيكون المراد بكونه شهيداً على كفران نفسه بكفران نفسه علمه المذموم و تحمّله له.
فالمعنى و إنّ الإنسان على كفرانه بربّه شاهد متحمّل فالآية في معنى قوله:( بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) القيامة: 14.
و قيل: الضمير لله و اتّساق الضمائر لا يلائمه.
قوله تعالى: ( وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ) قيل: اللّام في( لِحُبِّ الْخَيْرِ ) للتعليل و الخير المال، و المعنى و إنّ الإنسان لأجل حبّ المال لشديد أي بخيل شحيح، و قيل: المراد أنّ الإنسان لشديد الحبّ للمال و يدعوه ذلك إلى الامتناع من إعطاء حقّ الله، و الإنفاق في الله. كذا فسّروا.
و لا يبعد أن يكون المراد بالخير مطلقة و يكون المراد أنّ حبّ الخير فطريّ للإنسان ثمّ إنّه يرى عرض الدنيا و زينتها خيراً فتنجذب إليه نفسه و ينسيه ذلك ربّه أن يشكره.
قوله تعالى: ( أَ فَلا يَعْلَمُ إِذا بُعْثِرَ ما فِي الْقُبُورِ - إلى قوله -لَخَبِيرٌ ) البعثرة كالبحثرة البعث و النشر، و تحصيل ما في الصدور تمييز ما في باطن النفوس من صفة
الإيمان و الكفر و رسم الحسنة و السيّئة قال تعالى:( يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ ) الطارق: 9، و قيل: هو إظهار ما أخفته الصدور لتجازى على السرّ كما تجازى على العلانية.
و قوله:( أَ فَلا يَعْلَمُ ) الاستفهام فيه للإنكار، و مفعول يعلم جملة قائمة مقام المفعولين يدلّ عليه المقام. ثمّ استؤنف فقيل: إذا بعثر ما في القبور إلخ تأكيداً للإنكار، و المراد بما في القبور الأبدان.
و المعنى - و الله أعلم - أ فلا يعلم الإنسان أنّ لكنوده و كفرانه بربّه تبعة ستلحقه و يجازى بها، إذا اُخرج ما في القبور من الأبدان و حصّل و ميّز ما في سرائر النفوس من الإيمان و الكفر و الطاعة و المعصية إنّ ربّهم بهم يومئذ لخبير فيجازيهم بما فيها.
( بحث روائي)
في المجمع: قيل: بعث رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم سريّة إلى حيّ من كنانة فاستعمل عليهم المنذر بن عمرو الأنصاريّ أحد النقباء فتأخّر رجوعهم فقال المنافقون: قتلوا جميعاً فأخبر الله تعالى عنها بقوله:( وَ الْعادِياتِ ضَبْحاً ) عن مقاتل.
و قيل: نزلت السورة لمّا بعث النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم عليّاًعليهالسلام إلى ذات السلاسل فأوقع بهم و ذلك بعد أن بعث عليهم مراراً غيره من الصحابة فرجع كلّ منهم إلى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم . و هو المرويّ عن أبي عبداللهعليهالسلام في حديث طويل.
قال: و سمّيت هذه الغزوة ذات السلاسل لأنّه اُسر منهم و قتل و سبي و شدّ اُسراؤهم في الحبال مكتّفين كأنّهم في السلاسل.
و لما نزلت السورة خرج رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم إلى الناس فصلّى بهم الغداة و قرأ فيها( وَ الْعادِياتِ ) فلمّا فرغ من صلاته قال أصحابه: هذه سورة لم نعرفها فقال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : نعم إنّ عليّاً ظفر بأعداء الله و بشّرني بذلك جبريل في هذه الليلة فقدم عليّعليهالسلام بعد أيّام بالغنائم و الاُسارى.
( سورة القارعة مكّيّة و هي إحدى عشرة آية)
( سورة القارعة الآيات 1 - 11)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْقَارِعَةُ ( 1 ) مَا الْقَارِعَةُ ( 2 ) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ( 3 ) يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ( 4 ) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ( 5 ) فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ( 6 ) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ( 7 ) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ( 8 ) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ( 9 ) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ ( 10 ) نَارٌ حَامِيَةٌ ( 11 )
( بيان)
إنذار و تبشير بالقيامة يغلب فيه جانب الإنذار، و السورة مكّيّة.
قوله تعالى: ( الْقارِعَةُ مَا الْقارِعَةُ ) مبتدأ و خبر، و القارعة من القرع و هو الضرب باعتماد شديد، و هي من أسماء القيامة في القرآن. قيل: سمّيت بها لأنّها تقرع القلوب بالفزع و تقرع أعداء الله بالعذاب.
و السؤال عن حقيقة القارعة في قوله:( مَا الْقارِعَةُ ) مع كونها معلومة إشارة إلى تعظيم أمرها و تفخيمه و أنّها لا تكتنه علما، و قد اُكّد هذا التعظيم و التفخيم بقوله بعد:( وَ ما أَدْراكَ مَا الْقارِعَةُ ) .
قوله تعالى: ( يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ ) ظرف متعلّق بفعل مقدّر نحو اذكر و تقرع و تأتي، و الفراش على ما نقل عن الفراء الجراد الّذي ينفرش و يركب بعضه بعضاً و هو غوغاء الجراد. قيل: شبّه الناس عند البعث بالفراش لأنّ الفراش إذا ثار لم يتّجه إلى جهة واحدة كسائر الطير و كذلك الناس إذا خرجوا من قبورهم أحاط بهم الفزع فتوجّهوا جهات شتّى أو توجّهوا إلى منازلهم المختلفة
سعادة و شقاء. و المبعوث من البثّ و هو التفريق.
قوله تعالى: ( وَ تَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ) العهن الصوف ذو ألوان مختلفة، و المنفوش من النفش و هو نشر الصوف بندف و نحوه فالعهن المنفوش الصوف المنتشر ذو ألوان مختلفة إشارة إلى تلاشي الجبال على اختلاف ألوانها بزلزلة الساعة.
قوله تعالى: ( فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ ) إشارة إلى وزن الأعمال و أنّ الأعمال منها ما هو ثقيل في الميزان و هو ما له قدر و منزلة عندالله و هو الإيمان و أنواع الطاعات، و منها ما ليس كذلك و هو الكفر و أنواع المعاصي و يختلف القسمان أثراً فيستتبع الثقيل السعادة و يستتبع الخفيف الشقاء، و قد تقدّم البحث عن معنى الميزان في تفسير السور السابقة.
و قوله:( فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ ) العيشة بكسر العين كالجلسة بناء نوع، و توصيفها براضية - و الراضي صاحبها - من المجاز العقليّ أو المعنى في عيشة ذات رضى.
قوله تعالى: ( وَ أَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ ) الظاهر أنّ المراد بهاوية جهنّم و تسميتها بهاوية لهويّ من اُلقي فيها أي سقوطه إلى أسفل سافلين قال تعالى:( ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ) التين: 6.
فتوصيف النار بالهاوية مجاز عقليّ كتوصيف العيشة بالراضية و عدّ هاوية اُمّاً للداخل فيها لكونها مأواه و مرجعه الّذي يرجع إليه كما يرجع الولد إلى اُمّه.
و قيل: المراد باُمّه اُمّ رأسه و المعنى فاُمّ رأسه هاوية أي ساقطة فيها لأنّهم يلقون في النار على اُمّ رأسهم، و يبعّده بقاء الضمير في قوله:( ما هِيَهْ ) بلا مرجع ظاهر.
قوله تعالى: ( وَ ما أَدْراكَ ما هِيَهْ ) ضمير هي لهاوية، و الهاء في( هِيَهْ ) للوقف و الجملة تفسير تفيد تعظيم أمر النار و تفخيمه.
قوله تعالى: ( نارٌ حامِيَةٌ ) أي حارّة شديدة الحرارة و هو جواب الاستفهام في( ما هِيَهْ ) و تفسير لهاوية.
( بحث روائي)
في تفسير القمّيّ: في قوله تعالى:( كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ) قال: العهن الصوف، و في قوله:( وَ أَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ ) قال: من الحسنات، و في قوله:( فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ ) قال: اُمّ رأسه، يقذف في النار على رأسه.
و في الدرّ المنثور، أخرج ابن مردويه عن أبي أيّوب الأنصاريّ أنّ رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: إنّ نفس المؤمن إذا قبضت يلقاها أهل الرحمة من عباد الله كما يلقون البشير من أهل الدنيا فيقولون: انظروا صاحبكم يستريح فإنّه كان في كرب شديد ثمّ يسألونه ما فعل فلان و فلانة؟ هل تزوّجت؟ فإذا سألوه عن الرجل قد مات قبله فيقول: هيهات قد مات ذاك قبلي فيقولون: إنّا لله و إنّا إليه راجعون ذُهب به إلى اُمّه الهاوية فبئست الاُمّ و بئست المربّية.
أقول: و روي هذا المعنى عن أنس بن مالك و عن الحسن و الأشعث بن عبدالله الأعمى عنهصلىاللهعليهوآلهوسلم .
( سورة التكاثر مكّيّة و هي ثمان آيات)
( سورة التكاثر الآيات 1 - 8)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ( 1 ) حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ( 2 ) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ( 3 ) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ( 4 ) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ( 5 ) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ( 6 ) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ( 7 ) ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ( 8 )
( بيان)
توبيخ شديد للناس على تلهّيهم بالتكاثر في الأموال و الأولاد و الأعضاء و غفلتهم عمّا وراءه من تبعة الخسران و العذاب، و تهديد بأنّهم سوف يعلمون و يرون ذلك و يسألون عن هذه النعم الّتي اُوتوها ليشكروا فتلهّوا بها و بدّلوا نعمة الله كفراً.
و السورة بما لها من السياق تحتمل المكّيّة و المدنيّة، و سيأتي ما ورد في سبب نزولها في البحث الروائيّ إن شاء الله.
قوله تعالى: ( أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ ) قال في المفردات: اللهو ما يشغل الإنسان عمّا يعنيه و يهمّه. قال، و يقال: ألهاه كذا أي شغله عمّا هو أهمّ إليه، قال تعالى:( أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ ) انتهى.
و قال: و المكاثرة و التكاثر التباري في كثرة المال و العزّ، انتهى. و قال: المقبرة - بكسر الميم - و المقبرة - بفتحها - موضع القبور و جمعها مقابر، قال تعالى:( حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ ) كناية عن الموت، انتهى.
فالمعنى على ما يعطيه السياق شغلكم التكاثر في متاع الدنيا و زينتها و التسابق
في تكثير العدّة و العدّة عمّا يهمّكم و هو ذكر الله حتّى لقيتم الموت فعمّتكم الغفلة مدى حياتكم.
و قيل: المعنى شغلكم التباهي و التباري بكثرة الرجال بأن يقول هؤلاء: نحن أكثر رجالاً، و هؤلاء: نحن أكثر حتّى إذا استوعبتم عدد الأحياء صرتم إلى القبور فعددتم الأموات من رجالكم فتكاثرتم بأمواتكم.
و هذا المعنى مبنيّ على ما ورد في أسباب النزول أنّ قبيلتين من الأنصار تفاخرتا بالأحياء ثمّ بالأموات، و في بعضها أنّ ذلك كان بمكّة بين بني عبد مناف و بني سهم فنزلت السورة، و سيأتي القصّة في البحث الروائيّ.
قوله تعالى: ( كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ) ردع عن اشتغالهم بما لا يهمّهم عمّا يعنيهم و تخطئة لهم، و قوله:( سَوْفَ تَعْلَمُونَ ) تهديد معناه على ما يفيده المقام سوف تعلمون تبعة تلهّيكم هذا و تعرفونها إذا انقطعتم عن الحياة الدنيا.
قوله تعالى: ( ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ) تأكيد للردع و التهديد السابقين، و قيل: المراد بالأوّل علمهم بها عند الموت و بالثاني علمهم بها عند البعث.
قوله تعالى: ( كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ) ردع بعد ردع تأكيداً و اليقين العلم الّذي لا يداخله شكّ و ريب.
و قوله:( لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ) جواب لو محذوف و التقدير لو تعلمون الأمر علم اليقين لشغلكم ما تعلمون عن التباهي و التفاخر بالكثرة، و قوله:( لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمََ ) استئناف في الكلام، و اللّام للقسم، و المعنى اُقسم لترونّ الجحيم الّتي جزاء هذا التلهّي كذا فسّروا.
قالوا: و لا يجوز أن يكون قوله:( لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ) جواب لو الامتناعيّة لأنّ الرؤية محقّق الوقوع و جوابها لا يكون كذلك.
و هذا مبنيّ على أن يكون المراد رؤية الجحيم يوم القيامة كما قال:( وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرى ) النازعات: 36 و هو غير مسلّم بل الظاهر أنّ المراد رؤيتها قبل يوم القيامة رؤية البصيرة و هي رؤية القلب الّتي هي من آثار اليقين على ما يشير إليه،
قوله تعالى:( وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ) الأنعام: 75، و قد تقدّم الكلام فيها، و هذه الرؤية القلبيّة قبل يوم القيامة غير محقّقة لهؤلاء المتلهّين بل ممتنعة في حقّهم لامتناع اليقين عليهم.
قوله تعالى: ( ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقِينِ ) المراد بعين اليقين نفسه، و المعنى لترونّها محض اليقين، و هذه بمشاهدتها يوم القيامة، و من الدليل عليه قوله بعد ذلك( ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ) فالمراد بالرؤية الاُولى رؤيتها قبل يوم القيامة و بالثانية رؤيتها يوم القيامة.
و قيل: الاُولى قبل الدخول فيها يوم القيامة و الثانية إذ دخلوها.
و قيل: الاُولى بالمعرفة و الثانية بالمشاهدة، و قيل: المراد الرؤية بعد الرؤية إشارة إلى الاستمرار و الخلود، و قيل غير ذلك و هي وجوه ضعيفة.
قوله تعالى: ( ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ) ظاهر السياق أنّ هذا الخطاب و كذلك الخطابات المتقدّمة في السورة للناس بما أنّ فيهم من اشتغل بنعمة ربّه عن ربّه فأنساه التكاثر فيها عن ذكر الله، و ما في السورة من التوبيخ و التهديد متوجّه إلى عامّة الناس ظاهراً واقع على طائفة خاصّة منهم حقيقة و هم الّذين ألهاهم التكاثر.
و كذا ظاهر السياق أنّ المراد بالنعيم مطلقة و هو كلّ ما يصدق عليه أنّه نعمة فالإنسان مسؤل عن كلّ نعمة أنعم الله بها عليه.
و ذلك أنّ النعمة - و هي الأمر الّذي يلائم المنعم عليه و يتضمّن له نوعاً من الخير و النفع - إنّما تكون نعمة بالنسبة إلى المنعم عليه إذا استعملها بحيث يسعد بها فينتفع و أمّا لو استعملها على خلاف ذلك كانت نقمة بالنسبة إليه و إن كانت نعمة بالنظر إلى نفسها.
و قد خلق الله تعالى الإنسان و جعل غاية خلقته الّتي هي سعادته و منتهى كماله التقرّب العبوديّ إليه كما قال:( وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ) الذاريات: 56 و هي الولاية الإلهيّة لعبده، و قد هيّأ الله سبحانه له كلّ ما يسعد و ينتفع به في سلوكه نحو الغاية الّتي خلق لها و هي النعم فأسبغ عليه نعمه ظاهرة و باطنة.
فاستعمال هذه النعم على نحو يرتضيه الله و ينتهي بالإنسان إلى غايته المطلوبة هو الطريق إلى بلوغ الغاية و هو الطاعة، و استعمالها بالجمود عليها و نسيان ما وراءها غيّ و ضلال و انقطاع عن الغاية و هو المعصية، و قد قضى سبحانه قضاء لا يردّ و لا يبدّل أن يرجع الإنسان إليه فيسأله عن عمله فيحاسبه و يجزيه، و عمله هو استعماله للنعم الإلهيّة قال تعالى:( وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى ثُمَّ يُجْزاهُ الْجَزاءَ الْأَوْفى وَ أَنَّ إِلى رَبِّكَ الْمُنْتَهى ) النجم: 42، فالسؤال عن عمل العبد سؤال عن النعيم كيف استعمله أ شكر النعمة أم كفر بها؟
( بحث روائي)
في المجمع، قيل: نزلت في اليهود قالوا: نحن أكثر من بني فلان، و بنو فلان أكثر من بني فلان ألهاهم ذلك حتّى ماتوا ضلالاً: عن قتادة.
و قيل: نزلت في فخذ من الأنصار تفاخروا: عن أبي بريدة، و قيل: نزلت في حيّين من قريش: بني عبد مناف بن قصيّ و بني سهم بن عمر و تكاثروا و عدّوا أشرافهم فكثرهم بنو عبد مناف. ثمّ قالوا: نعدّ موتانا حتّى زاروا القبور فعدّوهم و قالوا: هذا قبر فلان و هذا قبر فلان فكثرهم بنو سهم لأنّهم كانوا أكثر عدداً في الجاهليّة: عن مقاتل و الكلبيّ.
و في تفسير البرهان، عن البرقيّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبداللهعليهالسلام في قوله تعالى:( لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ) قال: المعاينة.
أقول: الرواية تؤيّد ما قدّمناه من المعنى.
و في تفسير القمّيّ، بإسناده عن جميل عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قلت له:( لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ) قال: تسأل هذه الاُمّة عمّا أنعم الله عليها برسوله ثمّ بأهل بيته.
و في الكافي، بإسناده عن أبي خالد الكابليّ قال: دخلت على أبي جعفرعليهالسلام فدعا بالغذاء فأكلت معه طعاماً ما أكلت طعاماً أطيب منه قطّ و لا ألطف فلمّا فرغنا من
الطعام قال: يا أبا خالد كيف رأيت طعامك؟ أو قال: طعامنا؟ قلت: جعلت فداك ما أكلت طعاماً أطيب منه قطّ و لا أنظف و لكن ذكرت الآية الّتي في كتاب الله عزّوجلّ:( ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ) فقال أبوجعفرعليهالسلام : إنّما يسألكم عمّا أنتم عليه من الحقّ.
و فيه، بإسناده عن أبي حمزة قال: كنّا عند أبي عبداللهعليهالسلام جماعة فدعا بطعام ما لنا عهد بمثله لذاذة و طيباً و اُتينا بتمر تنظر فيه أوجهنا من صفائه و حسنه فقال رجل: لتسألن عن هذا النعيم الّذي تنعّمتم به عند ابن رسول الله فقال أبو عبدالله إنّ الله عزّوجلّ أكرم و أجلّ أن يطعم طعاماً فيسوّغكموه ثمّ نسألكم عنه إنّما يسألكم عمّا أنعم عليكم بمحمّد و آل محمّدصلىاللهعليهوآلهوسلم .
أقول: و هذا المعنى مرويّ عن أئمّة أهل البيتعليهمالسلام بطرق اُخرى و عبارات مختلفة و في بعضها أنّ النعيم ولايتنا أهل البيت، و يؤل المعنى إلى ما قدّمناه من عموم النعيم لكلّ نعمة أنعم الله بها بما أنّها نعمة.
بيان ذلك أنّ هذه النعم لو سئل عن شيء منها فليست يسأل عنها بما أنّها لحم أو خبز أو تمر أو ماء بارد أو أنّها سمع أو بصر أو يد أو رجل مثلاً و إنّما يسأل عنها بما أنّها نعمة خلقها الله للإنسان و أوقعها في طريق كماله و الحصول على التقرّب العبوديّ كما تقدّمت الإشارة إليه و ندبه إلى أن يستعملها شكراً لا كفراً.
فالمسؤل عنها هي النعمة بما أنّها نعمة، و من المعلوم أنّ الدالّ على نعيميّة النعيم و كيفيّة استعماله شكراً و المبيّن لذلك كلّه هو الدين الّذي جاء به النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم و نصب لبيانه الأئمّة من أهل بيته فالسؤال عن النعيم مرجعه السؤال عن العمل بالدين في كلّ حركة و سكون و من المعلوم أيضا أنّ السؤال عن النعيم الّذي هو الدين سؤال عن النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم و الأئمّة من بعده الّذين افترض الله طاعتهم و أوجب اتّباعهم في السلوك إلى الله الّذي طريقه استعمال النعم كما بيّنه الرسول و الأئمّة.
و إلى كون السؤال عن النعيم سؤالاً عن الدين يشير ما في رواية أبي خالد من قوله:( إنّما يسألكم عمّا أنتم عليه من الحقّ) .
و إلى كونه سؤالاً عن النعيم الّذي هو النبيّ و أهل بيته يشير ما في روايتي جميل و أبي حمزة السابقتين من قوله:( يسأل هذه الاُمّة عمّا أنعم الله عليها برسوله ثمّ بأهل بيته) أو ما في معناه، و في بعض الروايات:( النعيم هو رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم أنعم الله به على أهل العالم فاستنقذهم من الضلالة) ، و في بعضها: أنّ النعيم ولايتنا أهل البيت، و المال واحد و من ولاية أهل البيت افتراض طاعتهم و اتّباعهم فيما يسلكونه من طريق العبوديّة.
و في المجمع، و قيل: النعيم الصحّة و الفراغ: عن عكرمة، و يعضده ما رواه ابن عبّاس عن النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة و الفراغ.
و فيه، و قيل: هو يعني النعيم الأمن و الصحّة: عن عبدالله بن مسعود و مجاهد، و روي ذلك عن أبي جعفر و أبي عبداللهعليهماالسلام .
أقول: و في روايات اُخرى من طرق أهل السنّة أنّ النعيم هو التمر و الماء البارد و في بعضها غيرهما، و ينبغي أن يحمل الجميع على إيراد المثال.
و في الحديث النبويّ من طرقهم أيضاً: ثلاث لا يسأل عنها العبد: خرقة يواري بها عورته أو كسرة يسدّ بها جوعته أو بيت يكنّه من الحرّ و البرد. الحديث، و ينبغي أن يحمل على خفّة الحساب في الضروريّات و نفي المناقشة فيه و الله أعلم.
( سورة العصر مكّيّة و هي ثلاث آيات)
( سورة العصر الآيات 1 - 3)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ ( 1 ) إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ( 2 ) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ( 3 )
( بيان)
تلخّص السورة جميع المعارف القرآنيّة و تجمع شتات مقاصد القرآن في أوجز بيان، و هي تحتمل المكّيّة و المدنيّة لكنّها أشبه بالمكّيّة.
قوله تعالى: ( وَ الْعَصْرِ ) إقسام بالعصر و الأنسب لما تتضمّنه الآيتان التاليتان من شمول الخسران للعالم الإنسانيّ إلّا لمن اتّبع الحقّ و صبر عليه و هم المؤمنون الصالحون عملاً، أن يكون المراد بالعصر عصر النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم و هو عصر طلوع الإسلام على المجتمع البشريّ و ظهور الحقّ على الباطل.
و قيل: المراد به وقت العصر و هو الطرف الأخير من النهار لما فيه من الدلالة على التدبير الربوبيّ بإدبار النهار و إقبال الليل و ذهاب سلطان الشمس، و قيل: المراد به صلاة العصر و هي الصلاة الوسطى الّتي هي أفضل الفرائض اليوميّة، و قيل الليل و النهار و يطلق عليهما العصران، و قيل الدهر لما فيه من عجائب الحوادث الدالّة على القدرة الربوبيّة و غير ذلك.
و قد ورد في بعض الروايات أنّه عصر ظهور المهديّعليهالسلام لما فيه من تمام ظهور الحقّ على الباطل.
قوله تعالى: ( إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ ) المراد بالإنسان جنسه، و الخسر و الخسران و الخسار و الخسارة نقص رأس المال قال الراغب: و ينسب ذلك إلى الإنسان
فيقال: خسر فلان و إلى الفعل فيقال: خسرت تجارته، انتهى. و التنكير في( خُسْرٍ ) للتعظيم و يحتمل التنويع أي في نوع من الخسر غير الخسارات الماليّة و الجاهيّة قال تعالى:( الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَلا ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ ) الزمر: 15.
قوله تعالى: ( إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ) استثناء من جنس الإنسان الواقع في الخسر، و المستثنون هم الأفراد المتلبّسون بالإيمان و الأعمال الصالحة فهم آمنون من الخسر.
و ذلك أنّ كتاب الله يبيّن أنّ للإنسان حياة خالدة مؤبّدة لا تنقطع بالموت و إنّما الموت انتقال من دار إلى دار كما تقدّم في تفسير قوله تعالى:( عَلى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثالَكُمْ وَ نُنْشِئَكُمْ فِي ما لا تَعْلَمُونَ ) الواقعة: 61، و يبيّن أنّ شطراً من هذه الحياة و هي الحياة الدنيا حياة امتحانيّة تتعيّن بها صفة الشطر الأخير الّذي هو الحياة الآخرة المؤبّدة من سعادة و شقاء قال تعالى:( وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتاعٌ ) الرعد: 26، و قال:( كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً ) الأنبياء: 35.
و يبيّن أنّ مقدّميّة هذه الحياة لتلك الحياة إنّما هي بمظاهرها من الاعتقاد و العمل فالاعتقاد الحقّ و العمل الصالح ملاك السعادة الاُخرويّة و الكفر و الفسوق ملاك الشقاء فيها قال تعالى:( وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى ثُمَّ يُجْزاهُ الْجَزاءَ الْأَوْفى ) ، و قال:( مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَ مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ) الروم: 44، و قال:( مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَساءَ فَعَلَيْها ) حم السجدة: 46، و قد سمّى الله تعالى ما سيلقاه الإنسان في الآخرة جزاء و أجراً في آيات كثيرة.
و يتبيّن بذلك كلّه أنّ الحياة رأس مال للإنسان يكسب به ما يعيش به في حياته الآخرة فإن اتّبع الحقّ في العقد و العمل فقد ربحت تجارته و بورك في مكسبه و أمن الشرّ في مستقبله، و إن اتّبع الباطل و أعرض عن الإيمان و العمل الصالح فقد خسرت تجارته و حرم الخير في عقباه و هو قوله تعالى:( إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ
آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ) .
و المراد بالإيمان الإيمان بالله و من الإيمان بالله الإيمان بجميع رسله و الإيمان باليوم الآخر فقد نصّ تعالى فيمن لم يؤمن ببعض رسله(1) أو باليوم الآخر أنّه غير مؤمن بالله.
و ظاهر قوله:( وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ) التلبّس بجميع الأعمال الصالحة فلا يشمل الاستثناء الفسّاق بترك بعض الصالحات من المؤمنين و لازمه أن يكون الخسر أعمّ من الخسر في جميع جهات حياته كما في الكافر المعاند للحقّ المخلّد في العذاب، و الخسر في بعض جهات حياته كالمؤمن الفاسق الّذي لا يخلّد في النار و ينقطع عنه العذاب بشفاعة و نحوها.
قوله تعالى: ( وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ ) التواصي بالحقّ هو أن يوصي بعضهم بعضاً بالحقّ أي باتّباعه و الدوام عليه فليس دين الحقّ إلّا اتّباع الحقّ اعتقاداً و عملاً و التواصي بالحقّ أوسع من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لشموله الاعتقاديات و مطلق الترغيب و الحثّ على العمل الصالح.
ثمّ التواصي بالحقّ من العمل الصالح فذكره بعد العمل الصالح من قبيل ذكر الخاصّ بعد العامً اهتماماً بأمره كما أنّ التواصي بالصبر من التواصي بالحقّ و ذكره بعده من ذكر الخاصّ بعد العامّ اهتماماً بأمره، و يؤكّد تكرار ذكر التواصي حيث قال:( وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ ) و لم يقل: و تواصوا بالحقّ و الصبر.
و على الجملة ذكر تواصيهم بالحقّ و بالصبر بعد ذكر تلبّسهم بالإيمان و العمل الصالح للإشارة إلى حياة قلوبهم و انشراح صدورهم للإسلام لله فلهم اهتمام خاصّ و اعتناء تامّ بظهور سلطان الحقّ و انبساطه على الناس حتّى يتّبع و يدوم اتّباعه قال تعالى:( أَ فَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ أُولئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ ) الزمر: 22.
____________________
(1) النساء: 150 - 151.
و قد اُطلق الصبر فالمراد به أعمّ من الصبر على طاعة الله، و الصبر عن معصيته، و الصبر عند النوائب الّتي تصيبه بقضاء من الله و قدر.
( بحث روائي)
في تفسير القمّيّ، بإسناده عن عبدالرحمن بن كثير عن أبي عبداللهعليهالسلام في قوله تعالى:( إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ) إلخ، فقال: استثنى أهل صفوته من خلقه.
أقول: و طبق في ذيل الرواية الإيمان على الإيمان بولاية عليّعليهالسلام ، و التواصي بالحقّ على توصيتهم ذرّيّاتهم و أخلافهم بها.
و في الدرّ المنثور، أخرج ابن مردويه عن ابن عبّاس في قوله:( وَ الْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ ) يعني أباجهل بن هشام( إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ) ذكر عليّاً و سلمان.
( سورة الهمزة مكّيّة و هي تسع آيات)
( سورة الهمزة الآيات 1 - 9)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ( 1 ) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ( 2 ) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ( 3 ) كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ( 4 ) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ( 5 ) نَارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ ( 6 ) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ( 7 ) إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ( 8 ) فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ( 9 )
( بيان)
وعيد شديد للمغرمين بجمع المال المستعلين به على الناس المستكبرين عليهم فيزرون بهم و يعيبونهم بما ليس بعيب، و السورة مكّيّة.
قوله تعالى: ( وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ) قال في المجمع: الهمزة الكثير الطعن على غيره بغير حقّ العائب له بما ليس بعيب، و أصل الهمز الكسر. قال: و اللمز العيب أيضاً و الهمزة و اللمزة بمعنى، و قد قيل: بينهما فرق فإنّ الهمزة الّذي يعيبك بظهر الغيب، و اللمزة الّذي يعيبك في وجهك. عن الليث.
و قيل: الهمزة الّذي يؤذي جليسه بسوء لفظه، و اللمزة الّذي يكسر عينه على جليسه و يشير برأسه و يومئ بعينه. قال: و فعله بناء المبالغة في صفة من يكثر منه الفعل و يصير عادة له تقول: رجل نكحة كثير النكاح و ضحكة كثير الضحك و كذا همزة و لمزة انتهى.
فالمعنى ويل لكلّ عيّاب مغتاب، و فسّر بمعان اُخر على حسب اختلافهم في تفسير الهمزة و اللمزة.
قوله تعالى: ( الَّذِي جَمَعَ مالًا وَ عَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ ) بيان لهمزة لمزة
و تنكير( مالًا ) للتحقير فإنّ المال و إن كثر ما كثر لا يغني عن صاحبه شيئاً غير أنّ له منه ما يصرفه في حوائج نفسه الطبيعيّة من أكلة تشبعه و شربة ماء ترويه و نحو ذلك و( عَدَّدَهُ ) من العدّ بمعنى الإحصاء أي إنّه لحبّه المال و شغفه بجمعه يجمع المال و يعدّه عدّاً بعد عدّ التذاذاً بتكثّره. و قيل: المعنى جعله عدّة و ذخراً لنوائب الدهر.
و قوله:( يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ ) أي يخلده في الدنيا و يدفع عنه الموت و الفناء فالماضي اُريد به المستقبل بقرينة قوله:( يَحْسَبُ ) .
فهذا الإنسان لإخلاده إلى الأرض و انغماره في طول الأمل لا يقنع من المال بما يرتفع به حوائج حياته القصيرة و ضروريّات أيّامه المعدودة بل كلّما زاد مالاً زاد حرصاً إلى ما لا نهاية له فظاهر حاله أنّه يرى أنّ المال يخلده، و لحبّه الغريزيّ للبقاء يهتمّ بجمعه و تعديده، و دغاه ما جمعه و عدّده من المال و ما شاهده من الاستغناء إلى الطغيان و الاستعلاء على غيره من الناس كما قال تعالى:( إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى ) العلق 7، و يورثه هذا الاستكبار و التعدّي الهمز و اللمز.
و من هنا يظهر أنّ قوله:( يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ ) بمنزلة التعليل لقوله:( الَّذِي جَمَعَ مالًا وَ عَدَّدَهُ ) ، و قوله:( الَّذِي جَمَعَ ) إلخ بمنزلة التعليل لقوله:( وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ) .
قوله تعالى: ( كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ) ردع عن حسبانه الخلود بالمال، و اللّام في( لَيُنْبَذَنََّ ) للقسم، و النبذ القذف و الطرح، و الحطمة مبالغة من الحطم و هو الكسر و جاء بمعنى الأكل، و هي من أسماء جهنّم على ما يفسّرها قوله الآتي:( نارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ ) .
و المعنى ليس مخلّداً بالمال كما يحسب اُقسم ليموتنّ و يقذفنّ في الحطمة.
قوله تعالى: ( وَ ما أَدْراكَ مَا الْحُطَمَةُ ) تفخيم و تهويل.
قوله تعالى: ( نارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ) إيقاد النار إشعالها و الاطّلاع و الطلوع على الشيء الإشراف و الظهور، و الأفئدة جمع فؤاد و هو القلب، و المراد به في القرآن مبدأ الشعور و الفكر من الإنسان و هو النفس الإنسانيّة.
و كأنّ المراد من اطّلاعها على الأفئدة أنّها تحرق باطن الإنسان كما تحرق ظاهره بخلاف النار الدنيويّة الّتي إنّما تحرق الظاهر فقط قال تعالى:( وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ ) البقرة 24.
قوله تعالى: ( إِنَّها عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ ) أي مطبقة لا مخرج لهم منها و لا منجا.
قوله تعالى: ( فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ) العمد بفتحتين جمع عمود و التمديد مبالغة في المدّ قيل: هي أوتاد الأطباق الّتي تطبق على أهل النار، و قيل: عمد ممدّدة يوثقون فيها مثل المقاطر و هي خشب أو جذوع كبار فيها خروق توضع فيها أرجل المحبوسين من اللصوص و غيرهم، و قيل غير ذلك.
( بحث روائي)
في روح المعاني في قوله تعالى:( وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ) نزل ذلك على ما أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق عن عثمان بن عمر في اُبيّ بن خلف، و على ما أخرج عن السدي في اُبيّ بن عمر و الثقفيّ الشهير بالأخنس بن شريق فإنّه كان مغتاباً كثير الوقيعة.
و على ما قال ابن إسحاق في اُميّة بن خلف الجمحي و كان يهمز النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم .
و على ما أخرج ابن جرير و غيره عن مجاهد في جميل بن عامر و على ما قيل في الوليد بن المغيرة و اغتيابه لرسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم و غضّه منه، و على قول في العاص بن وائل.
أقول: ثمّ قال: و يجوز أن يكون نازلاً في جمع من ذكر. انتهى و لا يبعد أن يكون من تطبيق الرواة و هو كثير في أسباب النزول.
و في تفسير القمّيّ في قوله تعالى:( وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ ) قال: الّذي يغمز الناس و يستحقر الفقراء، و قوله:( لُمَزَةٍ ) يلوي عنقه و رأسه و يغضب إذا رأى فقيراً أو سائلاً( الَّذِي جَمَعَ مالًا وَ عَدَّدَهُ ) قال: أعدّه و وضعه.
و فيه قوله تعالى:( الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ) قال: تلتهب على الفؤاد قال
أبو ذرّ رضي الله عنه: بشّر المتكبّرين بكيّ في الصدور و سحب على الظهور. قوله( إِنَّها عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ ) قال: مطبقة( فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ) قال: إذا مدّت العمد عليهم أكلت و الله الجلود.
و في المجمع، روى العيّاشيّ بإسناده عن محمّد بن النعمان الأحول عن حمران بن أعين عن أبي جعفرعليهالسلام قال: إنّ الكفّار و المشركين يعيّرون أهل التوحيد في النار و يقولون: ما نرى توحيدكم أغنى عنكم شيئاً و ما نحن و أنتم إلّا سواء قال: فيأنف لهم الربّ تعالى فيقول للملائكة: اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله ثمّ يقول للنبيّين: اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله ثمّ يقول للمؤمنين: اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله و يقول الله: أنا أرحم الراحمين اخرجوا برحمتي فيخرجون كما يخرج الفراش.
قال: ثمّ قال أبوجعفرعليهالسلام : ثمّ مدّت العمد و اُوصدت عليهم و كان و الله الخلود.
( سورة الفيل مكّيّة و هي خمس آيات)
( سورة الفيل الآيات 1 - 5)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ( 1 ) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ( 2 ) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ( 3 ) تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ( 4 ) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ( 5 )
( بيان)
فيها إشارة إلى قصّة أصحاب الفيل إذ قصدوا مكّة لتخريب الكعبة المعظّمة فأهلكهم الله بإرسال طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجّيل فجعلهم كعصف مأكول، و هي من آيات الله الجليّة الّتي لا سترة عليها، و قد أرّخوا بها و ذكرها الجاهليّون في أشعارهم، و السورة مكّيّة.
قوله تعالى: ( أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحابِ الْفِيلِ ) المراد بالرؤية العلم الظاهر ظهور الحسّ، و الاستفهام إنكاريّ، و المعنى أ لم تعلم كيف فعل ربّك بأصحاب الفيل، و قد كانت الواقعة عام ولد فيه النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم .
قوله تعالى: ( أَ لَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ) المراد بكيدهم سوء قصدهم بمكّة و إرادتهم تخريب البيت الحرام، و التضليل و الإضلال واحد، و جعل كيدهم في تضليل جعل سعيهم ضالّاً لا يهتدى إلى الغاية المقصودة منه فقد ساروا لتخريب الكعبة و انتهى بهم إلى هلاك أنفسهم.
قوله تعالى: ( وَ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبابِيلَ ) الأبابيل - كما قيل - جماعات في تفرقة زمرة زمرة، و المعنى و أرسل الله على أصحاب الفيل جماعات متفرّقة من الطير و الآية و الّتي تتلوها عطف تفسير على قوله:( أَ لَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ) .
قوله تعالى: ( تَرْمِيهِمْ بِحِجارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ ) أي ترمي أبابيل الطير أصحاب الفيل بحجارة من سجّيل، و قد تقدّم معنى السجّيل في تفسير قصص قوم لوط.
قوله تعالى: ( فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ ) العصف ورق الزرع و العصف المأكول ورق الزرع الّذي اُكل حبّه أو قشر الحبّ الّذي اُكل لبّه و المراد أنّهم عادوا بعد وقوع السجّيل عليهم أجساداً بلا أرواح أو أنّ الحجر بحرارته أحرق أجوافهم، و قيل: المراد ورق الزرع الّذي وقع فيها الأكال و هو أن يأكله الدود فيفسده و فسّرت الآية ببعض وجوه اُخر لا يناسب الأدب القرآنيّ.
( بحث روائي)
في المجمع: أجمعت الرواة على أنّ ملك اليمن الّذي قصد هدم الكعبة هو أبرهة بن الصباح الأشرم و قيل: إنّ كنيته أبو يكسوم و نقل عن الواقديّ أنّه جدّ النجاشي الّذي كان على عهد رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم .
ثمّ ساق الكلام في قصّة استيلائه على ملك اليمن إلى أن قال: ثمّ إنّه بنى كعبة باليمن و جعل فيها قباباً من ذهب فأمر أهل مملكته بالحجّ إليها يضاهي بذلك البيت الحرام، و إنّ رجلاً من بني كنانة خرج حتّى قدم اليمن فنظر إليها ثمّ قعد فيها يعني لحاجة الإنسان فدخلها أبرهة فوجد تلك العذرة فيها فقال: من اجترأ عليّ بهذا؟ و نصرانيّتي لأهدمنّ ذلك البيت حتّى لا يحجّه حاج أبداً و دعا بالفيل و أذّن قومه بالخروج و من اتّبعه من أهل اليمن، و كان أكثر من اتّبعه منهم عكّ و الأشعرون و خثعم.
قال: ثمّ خرج يسير حتّى إذا كان ببعض طريقه بعث رجلاً من بني سليم ليدعو الناس إلى حجّ بيته الّذي بناه فتلقاه أيضاً رجل من الحمس من بني كنانة فقتله فازداد بذلك حنقاً و حثّ السير و الانطلاق.
و طلب من أهل الطائف دليلاً فبعثوا معه رجلاً من هذيل يقال له نفيل فخرج
بهم يهديهم حتّى إذا كانوا بالمغمس نزلوه و هو من مكّة على ستّة أميال فبعثوا مقدّماتهم إلى مكّة فخرجت قريش عباديد في رؤوس الجبال و قالوا: لا طاقة لنا بقتال هؤلاء و لم يبق بمكّة غير عبد المطلب بن هاشم أقام على سقايته و غير شيبة بن عثمان بن عبد الدار أقام على حجابة البيت فجعل عبد المطّلب يأخذ بعضادتي الباب ثمّ يقول:
لا همّ أنّ المرء يمنع رحله فامنع جلالك
لا يغلبوا بصليبهم و محالهم عدواً محالك
لا يدخلوا البلد الحرام إذاً فأمر ما بدا لك
ثمّ إنّ مقدّمات أبرهة أصابت نعماً لقريش فأصابت فيها مائتي بعير لعبد المطلب بن هاشم فلمّا بلغه ذلك خرج حتّى أتى القوم، و كان حاجب أبرهة رجلاً من الأشعرين و كان له بعبد المطّلب معرفة فاستأذن له على الملك و قال له: أيّها الملك جاءك سيّد قريش الّذي يطعم إنسها في الحيّ و وحشها في الجبل فقال له: ائذن له.
و كان عبد المطّلب رجلاً جسيماً جميلاً فلمّا رآه أبو يكسوم أعظمه أن يجلسه تحته و كره أن يجلسه معه على سريره فنزل من سريره فجلس على الأرض و أجلس عبد المطّلب معه ثمّ قال: ما حاجتك؟ قال: حاجتي مائتا بعير لي أصابتها مقدّمتك فقال أبو يكسوم: و الله لقد رأيتك فأعجبتني ثمّ تكلّمت فزهدت فيك فقال: و لم أيّها الملك؟ قال: لأنّي جئت إلى بيت عزّكم و منعتكم من العرب و فضلكم في الناس و شرفكم عليهم و دينكم الّذي تعبدون فجئت لأكسره و اُصيبت لك مائتا بعير فسألتك عن حاجتك فكلّمتني في إبلك و لم تطلب إليّ في بيتكم.
فقال له عبد المطّلب: أيّها الملك أنا اُكلّمك في مالي و لهذا البيت ربّ هو يمنعه لست أنا منه في شيء فراع ذلك أبو يكسوم و أمر بردّ إبل عبد المطّلب عليه ثمّ رجع و أمست ليلتهم تلك الليلة كالحة نجومها كأنّها تكلّمهم كلاماً لاقترابها منهم فأحسّت نفوسهم بالعذاب.
إلى أن قال: حتّى إذا كان مع طلوع الشمس طلعت عليهم الطير معها الحجارة فجعلت ترميهم، و كلّ طائر في منقاره حجر و في رجليه حجران و إذا رمت بذلك مضت و طلعت اُخرى فلا يقع حجر من حجارتهم تلك على بطن إلّا خرقه و لا عظم إلّا أوهاه و ثقبه، و ثاب أبو يكسوم راجعاً قد أصابته بعض الحجارة فجعل كلّما قدم أرضاً انقطع له فيها إرب حتّى إذا انتهى إلى اليمن لم يبق شيء إلّا باده فلمّا قدمها تصدّع صدره و انشقّ بطنه فهلك و لم يصب من الأشعرين و خثعم أحد، الحديث.
أقول: و في الروايات اختلاف شديد في خصوصيّات القصّة من أراد الوقوف عليها فعليه بمطوّلات السير و التواريخ.
( سورة قريش مكّيّة و هي أربع آيات)
( سورة قريش الآيات 1 - 4)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ( 1 ) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ( 2 ) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ( 3 ) الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ( 4 )
( بيان)
تتضمّن السورة امتناناً على قريش بإيلافهم الرحلتين و تعقّبه بدعوتهم إلى التوحيد و عبادة ربّ البيت، و السورة مكّيّة.
و لمضمون السورة نوع تعلّق بمضمون سورة الفيل و لذا ذهب قوم من أهل السنّة إلى كون الفيل و لإيلاف سورة واحدة كما قيل بمثله في الضحى و أ لم نشرح لما بينهما من الارتباط كما نسب ذلك إلى المشهور بين الشيعة و الحقّ أنّ شيئاً ممّا استندوا إليه لا يفيد ذلك.
أمّا القائلون بذلك من أهل السنّة فإنّهم استندوا فيه إلى ما روي أنّ أبيّ بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه بالبسملة، و بما روي عن عمرو بن ميمون الأزديّ قال: صلّيت المغرب خلف عمر بن الخطّاب فقرأ في الركعة الاُولى و التين و في الثانية أ لم تر و لإيلاف قريش من غير أن يفصل بالبسملة.
و اُجيب عن الرواية الاُولى بمعارضتها بما روي أنّه أثبت البسملة بينهما في مصحفه، و عن الثانية بأنّ من المحتمل على تقدير صحّتها أن يكون الراوي لم يسمع قراءتها أو يكون قرأها سرّاً. على أنّها معارض بما روي عن النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم أنّ الله فضّل قريشاً بسبع خصال و فيها( و نزلت فيهم سورة من القرآن لم يذكر فيها أحد
غيرهم: لإيلاف قريش) . الحديث على أنّ الفصل متواتر.
و أمّا القائلون بذلك من الشيعة فاستندوا فيه إلى ما في المجمع، عن أبي العبّاس عن أحدهماعليهماالسلام قال: أ لم تر كيف فعل ربّك و لإيلاف قريش سورة واحدة، و ما في التهذيب، بإسناده عن العلاء عن زيد الشحّام قال: صلّى بنا أبوعبداللهعليهالسلام الفجر فقرأ الضحى و أ لم نشرح في ركعة، و ما في المجمع، عن العيّاشيّ عن المفضّل بن صالح عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: سمعته يقول: لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلّا الضحى و أ لم نشرح و أ لم تر كيف و لإيلاف قريش: و رواه المحقّق في المعتبر، نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر عن المفضّل: مثله.
أمّا رواية أبي العبّاس فضعيف لما فيها من الرفع.
و أمّا رواية الشحّام فقد رويت عنه أيضاً بطريقين آخرين: أحدهما ما في التهذيب، بإسناده عن ابن مسكان عن زيد الشحّام قال: صلّى بنا أبوعبداللهعليهالسلام فقرأ بنا بالضحى و أ لم نشرح، و ثانيهما عنه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زيد الشحّام قال: صلّى بنا أبوعبداللهعليهالسلام فقرأ في الاُولى الضحى و في الثانية أ لم نشرح لك صدرك.
و هذه أعني صحيحة ابن أبي عمير صريحة في قراءة السورتين في ركعتين و لا يبقى معها لرواية العلاء ظهور في الجمع بينهما، و أمّا رواية ابن مسكان فلا ظهور لها في الجمع و لا صراحة، و أمّا حمل ابن أبي عمير على النافلة فيدفعه قوله فيها:( صلّى بنا) فإنّه صريح في الجماعة و لا جماعة في نفل.
و أمّا رواية المفضّل فهي أدلّ على كونهما سورتين منها على كونهما سورة واحدة حيث قيل: لا تجمع بين سورتين ثمّ استثنى من السورتين الضحى و أ لم نشرح و كذا الفيل و لإيلاف.
فالحقّ أنّ الروايات إن دلّت فإنّما تدلّ على جواز القرآن بين سورتي الضحى و أ لم نشرح و سورتي الفيل و لإيلاف في ركعة واحدة من الفرائض و هو ممنوع في غيرها، و يؤيّده رواية الراونديّ في الخرائج، عن داود الرقّيّ عن أبي
عبداللهعليهالسلام في حديث قال: فلمّا طلع الفجر قام فأذّن و أقام و أقامني عن يمينه و قرأ في أوّل ركعة الحمد و الضحى و في الثانية بالحمد و قل هو الله أحد ثمّ قنت ثمّ سلّم ثمّ جلس.
قوله تعالى: ( لِإِيلافِ قُرَيْشٍ إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتاءِ وَ الصَّيْفِ ) الإلف بكسر الهمزة اجتماع مع التئام كما قاله الراغب و منه الاُلفة، و قال في الصحاح: و فلان قد ألف هذا الموضع بالكسر يألفه ألفاً و آلفه إيّاه غيره، و يقال أيضاً: آلفت الموضع اُولفه إيلافاً، انتهى.
و قريش عشيرة النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم و هم ولد النضر بن كنانة المسمّى قريشاً، و الرحلة حال السير على الراحلة و هي الناقة القويّة على السير كما في المجمع، و المراد بالرحلة خروج قريش من مكّة للتجارة و ذلك أنّ الحرم واد جديب لا زرع فيه و لا ضرع فكانت قريش تعيش فيه بالتجارة، و كانت لهم في كلّ سنة رحلتان للتجارة رحلة في الشتاء إلى اليمن و رحلة بالصيف إلى الشام، و كانوا يعيشون بذلك و كان الناس يحترمونهم لمكان البيت الحرام فلا يتعرضون لهم بقطع طريقهم أو الإغارة على بلدهم الأمن.
و قوله:( لِإِيلافِ قُرَيْشٍ ) اللّام فيه للتعليل، و فاعل الإيلاف هو الله سبحانه و قريش مفعوله الأوّل و مفعوله الثاني محذوف يدلّ عليه ما بعده، و قوله:( إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتاءِ وَ الصَّيْفِ ) بدل من إيلاف قريش، و فاعل إيلافهم هو الله و مفعوله الأوّل ضمير الجمع و مفعوله الثاني رحلة إلخ، و التقدير لإيلاف الله قريشاً رحلة الشتاء و الصيف.
قوله تعالى: ( يَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَيْتِ ) الفاء في( يَعْبُدُوا ) لتوهّم معنى الشرط أي أيّ شيء كان فليعبدوا ربّ هذا البيت لإيلافه أيّام الرحلتين أو لتوهّم التفصيل أي مهما يكن من شيء فليعبدوا ربّ هذا البيت إلخ، فهو كقوله تعالى:( وَ لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ) المدّثّر: 7.
و محصّل معنى الآيات الثلاث ليعبد قريش ربّ هذا البيت لأجل إيلافه إيّاهم رحلة الشتاء و الصيف و هم عائشون بذلك في أمن.
هذا بالنظر إلى كون السورة منفصلة عمّا قبلها ذات سياق مستقلّ في نفسها، و أمّا على تقدير كونها جزء من سورة الفيل متمّمة لها فذكروا أنّ اللّام في( لِإِيلافِ ) تعليلية متعلّقة بمقدّر يدلّ عليه المقام و المعنى فعلنا ذلك بأصحاب الفيل نعمة منّا على قريش مضافة إلى نعمتنا عليهم في رحلة الشتاء و الصيف فكأنّه قال: نعمة إلى نعمة و لذا قيل: إنّ اللّام مؤدّية معنى إلى و هو قول الفرّاء.
و قيل: المعنى فعلنا ذلك بأصحاب الفيل لتألف قريش بمكّة و يمكنهم المقام بها أو لنؤلف قريشاً فإنّهم هابوا من أبرهة لمّا قصدها و هربوا منه فأهلكناهم لترجع قريش إلى مكّة و يألفوا بها و يولد محمّدصلىاللهعليهوآلهوسلم فيبعث إلى الناس بشيراً و نذيراً هذا، و الكلام في استفادة هذه المعاني من السياق.
قوله تعالى: ( الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ) إشارة إلى ما في إيلافهم الرحلتين من منّه الواضح و نعمته الظاهرة عليهم و هو الإطعام و الأمن فيعيشون في أرض لا خصب فيها و لا أمن لغيرهم فليعبدوا ربّاً يدبّر أمرهم أحسن التدبير و هو ربّ البيت.
( بحث روائي)
في تفسير القمّيّ في قوله تعالى:( لِإِيلافِ قُرَيْشٍ إِيلافِهِمْ ) قال: نزلت في قريش لأنّه كان معاشهم من الرحلتين رحلة في الشتاء إلى اليمن، و رحلة في الصيف إلى الشام، و كانوا يحملون من مكّة الأدم و اللّب و ما يقع من ناحية البحر من الفلفل و غيره فيشترون بالشام الثياب و الدرمك و الحبوب، و كانوا يتألّفون في طريقهم و يثبتون في الخروج في كلّ خرجة رئيساً من رؤساء قريش و كان معاشهم من ذلك.
فلمّا بعث الله نبيّه استغنوا عن ذلك لأنّ الناس وفدوا على رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم و حجّوا إلى البيت فقال الله:( فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ) لا يحتاجون أن يذهبوا إلى الشام( وَ آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ) يعني خوف الطريق.
أقول: قوله: فلمّا بعث الله إلخ خفيّ الانطباق على سياق آيات السورة، و لعلّه من كلام القمّيّ أخذه من بعض ما روي عن ابن عبّاس.
( سورة الماعون مدنيّة أو مكّيّة و هي سبع آيات)
( سورة الماعون الآيات 1 - 7)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ( 1 ) فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ( 2 ) وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ( 3 ) فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ( 4 ) الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ( 5 ) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ( 6 ) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ( 7 )
( بيان)
وعيد لمن كان من المنتحلين بالدين متخلّقاً بأخلاق المنافقين كالسهو عن الصلاة و الرياء في الأعمال و منع الماعون ممّا لا يلائم التصديق بالجزاء.
و السورة تحتمل المكّيّة و المدنيّة، و قيل: نصفها مكّيّ و نصفها مدنيّ.
قوله تعالى: ( أَ رَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ) الرؤية تحتمل الرؤية البصريّة و تحتمل أن تكون بمعنى المعرفة، و الخطاب للنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم بما أنّه سامع فيتوجّه إلى كلّ سامع، و المراد بالدين الجزاء يوم الجزاء فالمكذّب بالدين منكر المعاد و قيل المراد به الدين بمعنى الملّة.
قوله تعالى: ( فَذلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ) الدعّ هو الردّ بعنف و جفاء، و الفاء في( فَذلِكَ ) لتوهّم معنى الشرط و التقدير أ رأيت الّذي يكذّب بالجزاء فعرفته بصفاته اللازمة لتكذيبه فإن لم تعرفه فذلك الّذي يردّ اليتيم بعنف و يجفوه و لا يخاف عاقبة عمله السيّئ و لو لم يكذّب به لخافها و لو خافها لرحمه.
قوله تعالى: ( وَ لا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ ) الحضّ الترغيب، و الكلام على تقدير مضاف أي لا يرغّب الناس على إطعام طعام المسكين قيل: إنّ التعبير بالطعام دون
الإطعام للإشعار بأنّ المسكين كأنّه مالك لما يعطى له كما في قوله تعالى:( وَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ ) الذاريات: 19 و قيل: الطعام في الآية بمعنى الإطعام.
و التعبير بالحضّ دون الإطعام لأنّ الحضّ أعمّ من الحضّ العمليّ الّذي يتحقّق بالإطعام.
قوله تعالى: ( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ ) أي غافلون لا يهتمّون بها و لا يبالون أن تفوتهم بالكلّيّة أو في بعض الأوقات أو تتأخّر عن وقت فضيلتها و هكذا.
و في الآية تطبيق من يكذّب بالدين على هؤلاء المصلّين لمكان فاء التفريع و دلالة على أنّهم لا يخلون من نفاق لأنّهم يكذّبون بالدين عملاً و هم يتظاهرون بالإيمان.
قوله تعالى: ( الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ ) أي يأتون بالعبادات لمراءاة الناس فهم يعملون للناس لا لله تعالى.
قوله تعالى: ( وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ ) الماعون كلّ ما يعين الغير في رفع حاجة من حوائج الحياة كالقرض تقرضه و المعروف تصنعه و متاع البيت تعيره و إلى هذا يرجع متفرّقات ما فسّر به في كلماتهم.
( بحث روائي)
في تفسير القمّيّ في قوله تعالى:( أَ رَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ) قال: نزلت في أبي جهل و كفّار قريش، و في قوله:( الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ ) قال: عنى به تاركون لأنّ كلّ إنسان يسهو في الصلاة قال أبوعبداللهعليهالسلام : تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لغير عذر.
و في الخصال، عن عليّعليهالسلام في حديث الأربعمائة قال: ليس عمل أحبّ إلى الله عزّوجلّ من الصلاة فلا يشغلنّكم عن أوقاتها شيء من اُمور الدنيا فإنّ الله عزّوجلّ
ذمّ أقواماً فقال:( الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ ) يعني أنّهم غافلون استهانوا بأوقاتها.
و في الكافي، بإسناده عن محمّد بن الفضيل قال: سألت عبداً صالحاًعليهالسلام عن قول الله عزّوجلّ:( الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ ) قال هو التضييع.
أقول: و في هذه المضامين روايات اُخر.
و في الدرّ المنثور، أخرج ابن جرير و ابن أبي حاتم و البيهقي في سننه عن عليّ بن أبي طالب( الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ ) قال: يراؤن بصلاتهم.
و فيه، أخرج أبونعيم و الديلميّ و ابن عساكر عن أبي هريرة عن النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم في قوله:( وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ ) قال: ما تعاون الناس بينهم الفأس و القدر و الدلو و أشباهه.
و في الكافي، بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبداللهعليهالسلام في حديث قال: و قوله عزّوجلّ:( وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ ) هو القرض تقرضه و المعروف تصنعه و متاع البيت تعيره و منه الزكاة.
أقول: و تفسير الماعون بالزكاة مرويّ من طرق أهل السنّة أيضاً عن عليّعليهالسلام كما في الدرّ المنثور، و لفظه: الماعون الزكاة المفروضة يراؤن بصلاتهم و يمنعون زكاتهم.
و في الدرّ المنثور، أخرج ابن قانع عن عليّ بن أبي طالب قال سمعت رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم يقول: المسلم أخو المسلم إذا لقيه حيّاه بالسلام و يردّ عليه ما هو خير منه لا يمنع الماعون قلت: يا رسول الله ما الماعون؟ قالصلىاللهعليهوآلهوسلم : الحجر و الحديد و الماء و أشباه ذلك.
أقول: و قد فسّرصلىاللهعليهوآلهوسلم في رواية اُخرى الحديد بقدور النحاس و حديد الفأس و الحجر بقدور الحجارة.
( سورة الكوثر مكّيّة و هي ثلاث آيات)
( سورة الكوثر الآيات 1 - 3)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ( 1 ) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ( 2 ) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ( 3 )
( بيان)
امتنان على النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم بإعطائه الكوثر و تطييب لنفسه الشريفة بأنّ شانئه هو الأبتر، و هي أقصر سورة في القرآن و قد اختلفت الروايات في كون السورة مكّيّة أو مدنيّة، و الظاهر أنّها مكّيّة، و ذكر بعضهم أنّها نزلت مرّتين جمعاً بين الروايات.
قوله تعالى: ( إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ ) قال في المجمع، الكوثر فوعل و هو الشيء الّذي من شأنه الكثرة، و الكوثر الخير الكثير، انتهى.
و قد اختلفت أقوالهم في تفسير الكوثر اختلافاً عجيباً فقيل: هو الخير الكثير، و قيل نهر في الجنّة، و قيل: حوض النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم في الجنّة أو في المحشر، و قيل: أولاده و قيل: أصحابه و أشياعهصلىاللهعليهوآلهوسلم إلى يوم القيامة، و قيل: علماء اُمّتهصلىاللهعليهوآلهوسلم ، و قيل القرآن و فضائله كثيرة، و قيل النبوّة و قيل: تيسير القرآن و تخفيف الشرائع و قيل: الإسلام و قيل التوحيد، و قيل: العلم و الحكمة، و قيل: فضائلهصلىاللهعليهوآلهوسلم ، و قيل المقام المحمود، و قيل: هو نور قلبهصلىاللهعليهوآلهوسلم إلى غير ذلك ممّا قيل، و قد نقل عن بعضهم أنّه أنهى الأقوال إلى ستّة و عشرين.
و قد استند في القولين الأوّلين إلى بعض الروايات، و باقي الأقوال لا تخلو من تحكّم و كيفما كان فقوله في آخر السورة:( إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ) - و ظاهر الأبتر هو المنقطع نسله و ظاهر الجملة أنّها من قبيل قصر القلب - أنّ كثرة ذرّيّتهصلىاللهعليهوآلهوسلم هي
المرادة وحدها بالكوثر الّذي اُعطيه النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم أو المراد بها الخير الكثير و كثرة الذرّيّة مرادة في ضمن الخير الكثير و لو لا ذلك لكان تحقيق الكلام بقوله:( إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ) خالياً عن الفائدة.
و قد استفاضت الروايات أنّ السورة إنّما نزلت فيمن عابهصلىاللهعليهوآلهوسلم بالبتر بعد ما مات ابناه القاسم و عبدالله، و بذلك يندفع ما قيل: إنّ مراد الشانئ بقوله:( الْأَبْتَرُ ) المنقطع عن قومه أو المنقطع عن الخير فردّ الله عليه بأنّه هو المنقطع من كلّ خير.
و لما في قوله:( إِنَّا أَعْطَيْناكَ ) من الامتنان عليهصلىاللهعليهوآلهوسلم جيء بلفظ المتكلّم مع الغير الدالّ على العظمة، و لما فيه من تطييب نفسه الشريفة اُكّدت الجملة بإنّ و عبّر بلفظ الإعطاء الظاهر في التمليك.
و الجملة لا تخلو من دلالة على أنّ ولد فاطمةعليهاالسلام ذرّيّتهصلىاللهعليهوآلهوسلم ، و هذا في نفسه من ملاحم القرآن الكريم فقد كثّر الله تعالى نسله بعده كثرة لا يعادلهم فيها أيّ نسل آخر مع ما نزل عليهم من النوائب و أفنى جموعهم من المقاتل الذريعة.
قوله تعالى: ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ ) ظاهر السياق في تفريع الأمر بالصلاة و النحر على الامتنان في قوله:( إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ ) أنّه من شكر النعمة و المعنى إذا مننّا عليك بإعطاء الكوثر فاشكر لهذه النعمة بالصلاة و النحر.
و المراد بالنحر على ما رواه الفريقان عن النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم و عن عليّعليهالسلام و روته الشيعة عن الصادقعليهالسلام و غيره من الأئمّة هو رفع اليدين في تكبير الصلاة إلى النحر.
و قيل: معنى الآية صلّ لربّك صلاة العيد و انحر البدن، و قيل: يعني صلّ لربّك و استو قائماً عند رفع رأسك من الركوع و قيل غير ذلك.
قوله تعالى: ( إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ) الشانئ هو المبغض و الأبتر من لا عقب له و هذا الشانئ هو العاص بن وائل.
و قيل: المراد بالأبتر المنقطع عن الخير أو المنقطع عن قومه، و قد عرفت أنّ
روايات سبب نزول السورة لا تلائمه و ستجيء.
( بحث روائي)
في الدرّ المنثور، أخرج البخاريّ و ابن جرير و الحاكم من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس أنّه قال: الكوثر الخير الّذي أعطاه إيّاه قال أبوبشر قلت لسعيد بن جبير فإنّ ناساً يزعمون أنّه نهر في الجنّة قال: النهر الّذي في الجنّة من الخير الّذي أعطاه الله إيّاه.
و فيه، أخرج ابن أبي حاتم و الحاكم و ابن مردويه و البيهقيّ في سننه عن عليّ بن أبي طالب قال: لمّا نزلت هذه السورة على النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم ( إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ ) قال النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم لجبريل: ما هذه النحيرة الّتي أمرني بها ربّي؟ قال: إنّها ليست بنحيرة و لكن يأمرك إذا تحرّمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبّرت و إذا ركعت و إذا رفعت رأسك من الركوع فإنّها صلاتنا و صلاة الملائكة الّذين في السماوات السبع، و إنّ لكلّ شيء زينة و زينة الصلاة رفع اليدين عند كلّ تكبيرة.
قال النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم : رفع اليدين من الاستكانة الّتي قال الله:( فَمَا اسْتَكانُوا لِرَبِّهِمْ وَ ما يَتَضَرَّعُونَ ) .
أقول: و رواه في المجمع، عن المقاتل عن الأصبغ بن نباتة عنهعليهالسلام ثمّ قال: أورده الثعلبيّ و الواحديّ في تفسيرهما، و قال أيضاً: إنّ جميع عترته الطاهرة رووا عنهعليهالسلام : أنّ معنى النحر رفع اليدين إلى النحر في الصلاة.
و فيه، أخرج ابن جرير عن أبي جعفر في قوله:( فَصَلِّ لِرَبِّكَ ) قال: الصلاة( وَ انْحَرْ ) قال يرفع يديه أوّل ما يكبّر في الافتتاح.
و فيه، أخرج ابن مردويه عن ابن عبّاس في قوله:( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ ) قال: إنّ الله أوحى إلى رسوله أن ارفع يديك حذاء نحرك إذا كبّرت للصلاة فذاك النحر.
و في المجمع، في الآية عن عمر بن يزيد قال سمعت أباعبداللهعليهالسلام يقول في قوله:( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ ) هو رفع يديك حذاء وجهك.
أقول: ثمّ قال: و روى عنه عبدالله بن سنان مثله، و روي أيضاً قريباً منه عن جميل عنهعليهالسلام .
و في الدرّ المنثور، أخرج ابن سعد و ابن عساكر من طريق الكلبيّ عن أبي صالح عن ابن عبّاس قال: كان أكبر ولد رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم القاسم ثمّ زينب ثمّ عبدالله ثمّ اُمّ كلثوم ثمّ فاطمة ثمّ رقيّة فمات القاسم و هو أوّل ميّت من ولده بمكّة ثمّ مات عبدالله فقال العاص بن وائل السهميّ قد انقطع نسله فهو أبتر فأنزل الله( إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ) .
و فيه، أخرج الزبير بن بكار و ابن عساكر عن جعفر بن محمّد عن أبيه قال: توفّي القاسم بن رسول الله بمكّة فمرّ رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم و هو آت من جنازته على العاص بن وائل و ابنه عمرو فقال حين رأى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّي لأشنؤه فقال العاص بن وائل: لا جرم لقد أصبح أبتر فأنزل الله( إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ) .
و فيه، أخرج ابن أبي حاتم عن السدّيّ قال: كانت قريش تقول - إذا مات ذكور الرجل - بتر فلان فلمّا مات ولد النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم قال العاص بن وائل: بتر و الأبتر الفرد.
أقول: و في بعض الآثار أنّ الشانئ هو الوليد بن المغيرة، و في بعضها أبوجهل و في بعضها عقبة بن أبي معيط، و في بعضها كعب بن الأشرف، و المعتمد ما تقدّم.
و يؤيّده ما في الاحتجاج الطبرسيّ، عن الحسن بن عليّعليهماالسلام : في حديث يخاطب فيه عمرو بن العاصي: و إنّك ولدت على فراش مشترك فتحاكمت فيك رجال قريش منهم أبوسفيان بن حرب و الوليد بن المغيرة و عثمان بن الحارث و النضر بن الحارث بن كلدة و العاص بن وائل كلّهم يزعم أنّك ابنه فغلبهم عليك من بين قريش ألأمهم حسباً
و أخبثهم منصباً و أعظمهم بغية.
ثمّ قمت خطيباً و قلت: أنا شانئ محمّد و قال العاص بن وائل: إنّ محمّداً رجل أبتر لا ولد له قد مات انقطع ذكره فأنزل الله تبارك و تعالى:( إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ) . الحديث.
و في تفسير القمّيّ:( إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ ) قال: الكوثر نهر في الجنّة أعطى الله محمّداًصلىاللهعليهوآلهوسلم عوضاً عن ابنه إبراهيم.
أقول: الخبر على إرساله و إضماره معارض لسائر الروايات و تفسير الكوثر بنهر في الجنّة لا ينافي التفسير بالخير الكثير كما تقدّم في خبر ابن جبير.
( سورة الكافرون مكّيّة و هي ست آيات)
( سورة الكافرون الآيات 1 - 6)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ( 1 ) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ( 2 ) وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ( 3 ) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ( 4 ) وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ( 5 ) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ( 6 )
( بيان)
فيها أمرهصلىاللهعليهوآلهوسلم أن يظهر للكفّار براءته من دينهم و يخبرهم بامتناعهم من دينه فلا دينه يتعدّاه إليهم و لا دينهم يتعدّاهم إليه فلا يعبد ما يعبدون أبداً و لا يعبدون ما يعبد أبداً فلييأسوا من أيّ نوع من المداهنة و المساهلة.
و اختلفوا في كون السورة مكّيّة أو مدنيّة، و الظاهر من سياقها أنّها مكّيّة.
قوله تعالى: ( قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ) الظاهر أنّ هؤلاء قوم معهودون لا كلّ كافر و يدلّ على ذلك أمرهصلىاللهعليهوآلهوسلم أن يخاطبهم ببراءته من دينهم و امتناعهم من دينه.
قوله تعالى: ( لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ ) الآية إلى آخر السورة مقول القول، و المراد بما تعبدون الأصنام الّتي كانوا يعبدونها، و مفعول( تَعْبُدُونَ ) ضمير راجع إلى الموصول محذوف لدلالة الكلام عليه و لرعاية الفواصل، و كذا مفاعيل الأفعال التالية:( أَعْبُدُ ) و( عَبَدْتُّمْ ) و( أَعْبُدُ ) .
و قوله:( لا أَعْبُدُ ) نفي استقباليّ فإنّ( لا ) لنفي الاستقبال كما أنّ( ما ) لنفي الحال، و المعنى لا أعبد أبداً ما تعبدونه اليوم من الأصنام.
قوله تعالى: ( وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ ) نفي استقباليّ أيضاً لعبادتهم ما يعبدهصلىاللهعليهوآلهوسلم و هو إخبار عن امتناعهم عن الدخول في دين التوحيد في مستقبل الأمر.
و بانضمام الأمر الّذي في مفتتح الكلام تفيد الآيتان أنّ الله سبحانه أمرني بالدوام على عبادته و أن اُخبركم أنّكم لا تعبدونه أبداً فلا يقع بيني و بينكم اشتراك في الدين أبداً.
فالآية في معنى قوله تعالى:( لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ) يس: 7، و قوله:( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ) البقرة: 6.
و كان من حقّ الكلام أن يقال: و لا أنتم عابدون من أعبد. لكن قيل: ما أعبد ليطابق ما في قوله:( لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ ) .
قوله تعالى: ( وَ لا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ ) تكرار لمضمون الجملتين السابقتين لزيادة التأكيد، كقوله:( كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ) التكاثر: 4 و قوله:( فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ) المدّثّر: 20.
و قيل: إنّ( ما ) في( ما عَبَدْتُّمْ ) و( ما أَعْبُدُ ) مصدرية لا موصولة و المعنى و لا أنا عابد عبادتكم و لا أنتم عابدون عبادتي أي لا اُشارككم و لا تشاركونني لا في المعبود و لا في العبادة فمعبودي هو الله و معبودكم الوثن و عبادتي ما شرعه الله لي و عبادتكم ما ابتدعتموه جهلاً و افتراء، و على هذا فالآيتان غير مسوقتين للتأكيد، و لا يخلو من بعد و سيأتي في البحث الروائيّ التالي وجه آخر للتكرار لطيف.
قوله تعالى: ( لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ ) تأكيد بحسب المعنى لما تقدّم من نفي الاشتراك، و اللّام للاختصاص أي دينكم و هو عبادة الأصنام يختصّ بكم و لا يتعدّاكم إليّ و ديني يختصّ بي و لا يتعدّاني إليكم و لا محلّ لتوهّم دلالة الآية على إباحة أخذ كلّ بما يرتضيه من الدين و لا أنّهصلىاللهعليهوآلهوسلم لا يتعرض لدينهم بعد ذلك فالدعوة الحقّة الّتي يتضمّنها القرآن تدفع ذلك أساساً.
و قيل: الدين في الآية بمعنى الجزاء و المعنى لكم جزاؤكم و لي جزائي، و قيل: إنّ هناك مضافاً محذوفاً و التقدير لكم جزاء دينكم و لي جزاء ديني، و الوجهان بعيدان عن الفهم.
( بحث روائي)
في الدرّ المنثور، أخرج ابن جرير و ابن أبي حاتم و ابن الأنباريّ في المصاحف عن سعيد بن ميناء مولى أبي البختريّ قال: لقي الوليد بن المغيرة و العاص بن وائل و الأسود بن المطّلب و اُميّة بن خلف رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فقالوا: يا محمّد هلمّ فلنعبد ما تعبد و تعبد ما نعبد و لنشترك نحن و أنت في أمرنا كلّه فإن كان الّذي نحن عليه أصحّ من الّذي أنت عليه كنت قد أخذت منه حظاً و إن كان الّذي أنت عليه أصحّ من الّذي نحن عليه كنّا قد أخذنا منه حظاً فأنزل الله( قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ ) حتّى انقضت السورة.
أقول: و روى الشيخ في الأمالي، بإسناده عن ميناء عن غير واحد من أصحابه قريباً منه.
و في تفسير القمّيّ، عن أبيه عن ابن أبي عمير قال: سأل أبوشاكر أباجعفر الأحول عن قول الله:( قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ وَ لا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ ) فهل يتكلّم الحكيم بمثل هذا القول، و يكرّر مرّة بعد مرّة؟ فلم يكن عند أبي جعفر الأحول في ذلك جواب.
فدخل المدينة فسأل أباعبداللهعليهالسلام عن ذلك فقال: كان سبب نزولها و تكرارها أنّ قريشاً قالت لرسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : تعبد آلهتنا سنة و نعبد إلهك سنة و تعبد آلهتنا سنة و نعبد إلهك سنة فأجابهم الله بمثل ما قالوا فقال فيما قالوا: تعبد آلهتنا سنة:( قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ ) ، و فيما قالوا: نعبد إلهك سنة:( وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ
ما أَعْبُدُ ) ، و فيما قالوا: تعبد آلهتنا سنة:( وَ لا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ ) و فيما قالوا: نعبد إلهك سنة:( وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ ) .
قال: فرجع أبو جعفر الأحول إلى أبي شاكر فأخبره بذلك فقال أبو شاكر: هذا حملته الإبل من الحجاز.
أقول: مفاد التكرار في كلام قريش الاستمرار على عبادة آلهتهم سنة و عبادة الله تعالى سنة.
( سورة النصر مدنيّة و هي ثلاث آيات)
( سورة النصر الآيات 1 - 3)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ( 1 ) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا ( 2 ) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ( 3 )
( بيان)
وعد لهصلىاللهعليهوآلهوسلم بالنصر و الفتح و أنّه سيرى الناس يدخلون في الإسلام فوجاً بعد فوج و أمره بالتسبيح حينئذ و التحميد و الاستغفار، و السورة مدنيّة نزلت بعد صلح الحديبيّة و قبل فتح مكّة على ما سنستظهر.
قوله تعالى: ( إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ وَ الْفَتْحُ ) ظهور( إذا ) المصدّرة بها الآية في الاستقبال يستدعي أن يكون مضمون الآية إخباراً بتحقّق أمر لم يتحقّق بعد، و إذا كان المخبر به هو النصر و الفتح و ذلك ممّا تقرّ به عين النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم فهو وعد جميل و بشرى لهصلىاللهعليهوآلهوسلم و يكون من ملاحم القرآن الكريم.
و ليس المراد بالنصر و الفتح جنسهما حتّى يصدقاً على جميع المواقف الّتي أيّد الله فيها نبيّهصلىاللهعليهوآلهوسلم على أعدائه و أظهر دينه على دينهم كما في حروبه و مغازيه و إيمان الأنصار و أهل اليمن كما قبل إذ لا يلائمه قوله بعد:( وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْواجاً ) .
و ليس المراد بذلك أيضاً صلح الحديبيّة الّذي سمّاه الله تعالى فتحاً إذ قال:( إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً ) الفتح: 1- لعدم انطباق الآية الثانية بمضمونها عليه.
و أوضح ما يقبل الانطباق عليه النصر و الفتح المذكوران في الآية هو فتح مكّة
الّذي هو اُمّ فتوحاتهصلىاللهعليهوآلهوسلم في زمن حياته و النصر الباهر الّذي انهدم به بنيان الشرك في جزيرة العرب.
و يؤيّده وعد النصر الّذي في الآيات النازلة في الحديبيّة( إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ وَ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ يَهْدِيَكَ صِراطاً مُسْتَقِيماً وَ يَنْصُرَكَ اللهُ نَصْراً عَزِيزاً ) الفتح: 3 فإنّ من القريب جدّاً أن يكون ما في الآيات وعداً بنصر عزيز يرتبط بفتح الحديبيّة و هو نصره تعالى نبيّهصلىاللهعليهوآلهوسلم على قريش حتّى فتح مكّة بعد مضيّ سنتين من فتح الحديبيّة.
و هذا الّذي ذكر أقرب من حمل الآية على إجابة أهل اليمن الدعوة الحقّة و دخولهم في الإسلام من غير قتال، فالأقرب إلى الاعتبار كون المراد بالنصر و الفتح نصره تعالى نبيّهصلىاللهعليهوآلهوسلم على قريش و فتح مكّة، و أن تكون السورة نازلة بعد صلح الحديبيّة و نزول سورة الفتح و قبل فتح مكّة.
قوله تعالى: ( وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْواجاً ) قال الراغب: الفوج الجماعة المارّة المسرعة، و جمعه أفواج. انتهى. فمعنى دخول الناس في دين الله أفواجاً دخولهم فيه جماعة بعد جماعة، و المراد بدين الله الإسلام قال تعالى:( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ ) آل عمران: 19.
قوله تعالى: ( فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كانَ تَوَّاباً ) لمّا كان هذا النصر و الفتح إذلالاً منه تعالى للشرك و إعزازاً للتوحيد و بعبارة اُخرى إبطالاً للباطل و إحقاقاً للحقّ ناسب من الجهة الاُولى تنزيهه تعالى و تسبيحه، و ناسب من الجهة الثانية - الّتي هي نعمة - الثناء عليه تعالى و حمده فلذلك أمرهصلىاللهعليهوآلهوسلم بقوله:( فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ) .
و ههنا وجه آخر يوجّه به الأمر بالتسبيح و التحميد و الاستغفار جميعاً و هو أنّ للربّ تعالى على عبده أن يذكره بصفات كماله و يذكر نفسه بما له من النقص و الحاجة و لمّا كان في هذا الفتح فراغهصلىاللهعليهوآلهوسلم من جلّ ما كان عليه من السعي في إماطة الباطل و قطع دابر الفساد أمر أن يذكره عند ذلك بجلاله و هو التسبيح و جماله
و هو التحميد و أن يذكره بنقص نفسه و حاجته إلى ربّه و هو طلب المغفرة و معناه فيهصلىاللهعليهوآلهوسلم - و هو مغفور - سؤال إدامة المغفرة فإنّ الحاجة إلى المغفرة بقاء كالحاجة إليها حدوثاً فافهم ذلك، و بذلك يتمّ شكره لربّه تعالى و قد تقدّم(1) كلام في معنى مغفرة الذنب في الأبحاث السابقة.
و قوله:( إِنَّهُ كانَ تَوَّاباً ) تعليل للأمر بالاستغفار لا يخلو من تشويق و تأكيد.
( بحث روائي)
في المجمع، عن مقاتل: لمّا نزلت هذه السورة قرأهاصلىاللهعليهوآلهوسلم على أصحابه ففرحوا و استبشروا و سمعها العبّاس فبكى فقالصلىاللهعليهوآلهوسلم ما يبكيك يا عمّ؟ قال: أظنّ أنّه قد نعيت إليك نفسك يا رسول الله فقال: إنّه لكما تقول فعاش بعدها سنتين ما رئي بعدها ضاحكاً مستبشراً.
أقول: و روي هذا المعنى في عدّة روايات بألفاظ مختلفة و قيل في وجه دلالتها أنّ سياقها يلوّح إلى فراغهصلىاللهعليهوآلهوسلم ممّا عليه من السعي و المجاهدة و تمام أمره، و عند الكمال يرقب الزوال.
و فيه، عن اُمّ سلمة قالت: كان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم بالآخرة لا يقوم و لا يقعد و لا يجيء و لا يذهب إلّا قال: سبحان الله و بحمده استغفر الله و أتوب إليه فسألناه عن ذلك فقال: إنّي اُمرت بها ثمّ قرأ( إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ وَ الْفَتْحُ ) .
أقول: و في هذا المعنى غير واحد من الروايات مع اختلاف مّا فيما كان يقولهصلىاللهعليهوآلهوسلم .
و في العيون، بإسناده إلى الحسين بن خالد قال: قال الرضاعليهالسلام سمعت أبي يحدّث عن أبيهعليهماالسلام : إنّ أوّل سورة نزلت( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ) و آخر سورة نزلت( إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ ) .
____________________
(1) في آخر الجزء السادس من الكتاب.
أقول: لعلّ المراد به أنّها آخر سورة نزلت تامّة كما قيل.
و في المجمع، في قصّة فتح مكّة: لمّا صالح رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم قريشاً عام الحديبيّة كان في أشراطهم أنّه من أحبّ أن يدخل في عهد رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم دخل فيه فدخلت خزاعة في عقد رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم و دخلت بنو بكر في عقد قريش، و كان بين القبيلتين شرّ قديم.
ثمّ وقعت فيما بعد بين بني بكر و خزاعة مقاتلة و رفدت قريش بني بكر بالسلاح و قاتل معهم من قريش من قاتل باللّيل مستخفياً، و كان ممّن أعان بني بكر على خزاعة بنفسه عكرمة بن أبي جهل و سهيل بن عمرو.
فركب عمرو بن سالم الخزاعيّ حتّى قدم على رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم المدينة و كان ذلك ممّا هاج فتح مكّة فوقف عليه و هو في المسجد بين ظهراني القوم و قال:
لا هم إني ناشد(1) محمدا |
حلف أبينا و أبيه الأتلدا(2) |
|
إن قريشا أخلفوك الموعدا |
و نقضوا ميثاقك المؤكدا |
و قتلونا ركعا و سجدا
فقال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : حسبك يا عمرو ثمّ قام فدخل دار ميمونة و قال: اسكبي لي ماء فجعل يغتسل و هو يقول: لا نصرت إن لم أنصر بني كعب و هم رهط عمرو بن سالم ثمّ خرج بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة حتّى قدموا على رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فأخبروه بما اُصيب منهم و مظاهرة قريش بني بكر عليهم ثمّ انصرفوا راجعين إلى مكّة و قد كانصلىاللهعليهوآلهوسلم قال للناس: كأنّكم بأبي سفيان قد جاء ليشدّد العقد و يزيد في المدّة و سيلقى بديل بن ورقاء فلقوا أبا سفيان بعسفان و قد بعثته قريش إلى النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم ليشدّد العقد.
فلمّا لقي أبوسفيان بديلاً قال: من أين أقبلت يا بديل قال: سرت في هذا الساحل و في بطن هذا الوادي قال: ما أتيت محمّداً؟ قال: لا فلمّا راح بديل إلى مكّة قال
____________________
(1) الناشد: الطالب و المذكر.
(2) الأتلد: القديم.
أبوسفيان: لئن كان جاء من المدينة لقد علّف بها النوى فعمد إلى مبرك ناقته و أخذ من بعرها ففتّه فرأى فيها النوى فقال: أحلف بالله لقد جاء بديل محمّداً.
ثمّ خرج أبوسفيان حتّى قدم إلى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فقال: يا محمّد احقن دم قومك و أجر بين قريش و زدنا في المدّة فقال: أ غدرتم يا أباسفيان؟ قال: لا فقالصلىاللهعليهوآلهوسلم : فنحن على ما كنّا عليه فخرج فلقي أبابكر فقال: أجر بين قريش قال: ويحك و أحد يجير على رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ؟ ثمّ لقي عمر بن الخطّاب فقال له مثل ذلك ثمّ خرج فدخل على اُمّ حبيبة فذهب ليجلس على الفراش فأهوت إلى الفراش فطوته فقال: يا بنيّة أ رغبت بهذا الفراش عنّي؟ فقالت: نعم هذا فراش رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ما كنت لتجلس عليه و أنت رجس مشرك.
ثمّ خرج فدخل على فاطمةعليهاالسلام فقال يا بنت سيّد العرب تجيرين بين قريش و تزيدين في المدّة فتكونين أكرم سيّدة في الناس؟ فقالت: جواري جوار رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم . قال: أ تأمرين ابنيك أن يجيرا بين الناس؟ قالت: و الله ما بلغ ابناي أن يجيرا بين الناس و ما يجير على رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم أحد فقال: يا أباالحسن إنّي أرى الاُمور قد اشتدّت عليّ فانصحني فقال عليّعليهالسلام : إنّك شيخ قريش فقم على باب المسجد و أجر بين قريش ثمّ الحقّ بأرضك قال: و ترى ذلك مغنياً عنّي شيئاً؟ قال: لا و الله ما أظنّ ذلك و لكن لا أجد لك غير ذلك فقام أبوسفيان في المسجد فقال: يا أيّها الناس إنّي قد أجرت بين قريش ثمّ ركب بعيره فانطلق.
فلمّا قدم على قريش قالوا: ما وراءك؟ فأخبرهم بالقصّة فقالوا: و الله إن زاد عليّ بن أبي طالب على أن لعب بك فما يغني عنّا ما قلت؟ قال: لا و الله ما وجدت غير ذلك.
قال: فأمر رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم بالجهاز لحرب مكّة و أمر الناس بالتهيئة و قال: اللّهمّ خذ العيون و الأخبار عن قريش حتّى نبغتها في بلادها، و كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش فأتى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم الخبر من السماء فبعث علياًعليهالسلام و الزبير حتّى أخذاً كتابه
من المرأة و قد مضت هذه القصّة في سورة الممتحنة.
ثمّ استخلف رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم أبا ذرّ الغفاريّ و خرج عامداً إلى مكّة لعشر مضين من شهر رمضان سنة ثمان في عشرة آلاف من المسلمين و نحو من أربعمائة فارس و لم يتخلّف من المهاجرين و الأنصار عنه أحد.
و قد كان أبوسفيان بن الحارث بن عبدالمطّلب و عبدالله بن اُميّة بن المغيرة قد لقيا رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم بنيق العقاب فيما بين مكّة و المدينة فالتمسا الدخول عليه فلم يأذن لهما فكلّمته اُمّ سلمة فيهما فقالت: يا رسول الله ابن عمّك و ابن عمّتك و صهرك قال لا حاجة لي فيهما أمّا ابن عمّي فهتك عرضي، و أمّا ابن عمّتي و صهري فهو الّذي قال لي بمكّة ما قال فلمّا خرج الخبر إليهما بذلك و مع أبي سفيان بنيّ له قال: و الله ليأذننّ لي أو لآخذنّ بيد بنيّ هذا ثمّ لنذهبنّ في الأرض حتّى نموت عطشاً و جوعاً فلمّا بلغ ذلك رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم رقّ لهما فأذن لهما فدخلاً عليه فأسلما.
فلمّا نزل رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم مرّ الظهران و قد غمّت الأخبار عن قريش فلا يأتيهم عن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم خبر خرج في تلك الليلة أبوسفيان بن حرب و حكيم بن حزام و بديل بن ورقاء يتجسّسون الأخبار و قد قال العبّاس ليلتئذ: يا سوء صباح قريش و الله لئن بغتها رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم في بلادها فدخل مكّة عنوة أنّه لهلاك قريش إلى آخر الدهر فخرج على بغلة رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم و قال: أخرج إلى الأراك لعلّي أرى حطّاباً أو صاحب لبن أو داخلاً يدخل مكّة فيخبرهم بمكان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فيأتونه فيستأمنونه.
قال العبّاس فوالله إنّي لأطوف في الأراك ألتمس ما خرجت له إذ سمعت صوت أبي سفيان و حكيم بن حزام و بديل بن ورقاء و سمعت أباسفيان يقول: و الله ما رأيت كالليلة قطّ نيراناً فقال بديل: هذه نيران خزاعة فقال أبوسفيان: خزاعة الأم من ذلك قال: فعرفت صوته فقلت: يا أبا حنظلة يعني أباسفيان فقال: أبوالفضل؟ فقلت: نعم قال: لبّيك فداك أبي و اُمّي ما وراءك؟ فقلت: هذا رسول الله وراءك قد جاء بما لا قبل لكم به بعشرة آلاف من المسلمين.
قال: فما تأمرني؟ قلت: تركب عجز هذه البغلة فاستأمن لك رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم
فوالله لئن ظفر بك ليضربنّ عنقك فردفني فخرجت أركض به بغلة رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فكلّما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا: هذا عمّ رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم على بغلة رسول الله حتّى مررت بنار عمر بن الخطّاب فقال يعني عمر: يا أباسفيان الحمد لله الّذي أمكن منك بغير عهد و لا عقد ثمّ اشتدّ نحو رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم و ركضت البغلة حتّى اقتحمت باب القبّة و سبقت عمر بما يسبق به الدابّة البطيئة الرجل البطيء.
فدخل عمر فقال: يا رسول الله هذا أبوسفيان عدوّ الله قد أمكن الله منه بغير عهد و لا عقد فدعني أضرب عنقه فقلت: يا رسول الله إنّي قد أجرته ثمّ إنّي جلست إلى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم و أخذت برأسه و قلت: و الله لا يناجيه اليوم أحد دوني فلمّا أكثر فيه عمر قلت: مهلاً يا عمر فوالله ما يصنع هذا الرجل إلّا أنّه رجل من آل بني عبد مناف و لو كان من عديّ بن كعب ما قلت هذا قال: مهلاً يا عبّاس لإسلامك يوم أسلمت كان أحبّ إليّ من إسلام الخطاب لو أسلم فقالصلىاللهعليهوآلهوسلم : اذهب فقد آمنّاه حتّى تغدو به عليّ في الغداة.
قال: فلمّا أصبح غدوت به على رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فلمّا رآه قال: ويحك يا أباسفيان أ لم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلّا الله؟ فقال: بأبي أنت و اُمّي ما أوصلك و أكرمك و أرحمك و أحلمك و الله لقد ظننت أن لو كان معه إله لأغنى يوم بدر و يوم اُحد فقال: ويحك يا أباسفيان أ لم يأن لك أن تعلم أنّي رسول الله؟ فقال: بأبي أنت و اُمّي أمّا هذه فإنّ في النفس منها شيئاً قال العبّاس: فقلت له: ويحك اشهد بشهادة الحقّ قبل أن يضرب عنقك فتشهّد.
فقالصلىاللهعليهوآلهوسلم للعبّاس: انصرف يا عبّاس فاحبسه عند مضيق الوادي حتّى يمرّ عليه جنود الله قال: فحبسته عند خطم(1) الجبل بمضيق الوادي و مرّ عليه القبائل قبيلة قبيلة و هو يقول: من هؤلاء؟ و أقول: أسلم و جهينة و فلان حتّى مرّ رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم في الكتيبة الخضراء من المهاجرين و الأنصار في الحديد لا يرى منهم إلّا الحدق فقال: من هؤلاء يا أباالفضل؟ قلت: هذا رسول الله في المهاجرين و الأنصار فقال: يا أباالفضل
____________________
(1) خطم الجبل: أنفه.
لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماً، فقلت: ويحك أنّها النبوّة فقال: نعم إذاً.
و جاء حكيم بن حزام و بديل بن ورقاء رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم و أسلما و بايعاه فلمّا بايعاه بعثهما رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم بين يديه إلى قريش يدعوانهم إلى الإسلام و قال: من دخل دار أبي سفيان و هي بأعلى مكّة فهو آمن، و من دخل دار حكيم و هي بأسفل مكّة فهو آمن، و من أغلق بابه و كفّ يده فهو آمن.
و لمّا خرج أبوسفيان و حكيم من عند رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم عامدين إلى مكّة بعث في أثرهما الزبير بن العوّام و أمّره على خيل المهاجرين و أمره أن يغرز رايته بأعلى مكّة بالحجون و قال له: لا تبرح حتّى آتيك ثمّ دخل رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم مكّة و ضربت هناك خيمته، و بعث سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في مقدّمته، و بعث الخالد بن الوليد فيمن كان أسلم من قضاعة و بني سليم و أمره أن يدخل أسفل مكّة و يغرز رايته دون البيوت.
و أمرهم رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم جميعاً أن يكفّوا أيديهم و لا يقاتلوا إلّا من قاتلهم، و أمرهم بقتل أربعة نفر عبدالله بن سعد بن أبي سرح و الحويرث بن نفيل و ابن خطل و مقبس بن ضبابة و أمرهم بقتل قينتين كانتا تغنّيان بهجاء رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم و قال: اقتلوهم و إن وجدتموهم متعلّقين بأستار الكعبة فقتل عليّعليهالسلام الحويرث بن نفيل و إحدى القينتين و أفلتت الاُخرى، و قتل مقبس بن ضبابة في السوق، و أدرك ابن خطل و هو متعلّق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث و عمّار بن ياسر فسبق سعيد عمّاراً فقتله.
قال: و سعى أبوسفيان إلى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم و أخذ غرزه أي ركابه فقبّله ثمّ قال: بأبي أنت و اُمّي أ ما تسمع ما يقول سعد إنّه يقول:
اليوم يوم الملحمة |
اليوم تسبى الحرمة |
فقالصلىاللهعليهوآلهوسلم لعليّعليهالسلام : أدركه و خذ الراية منه و كن أنت الّذي يدخل بها و أدخلها إدخالاً رفيقاً فأخذها عليّعليهالسلام و أدخلها كما أمر.
و لمّا دخل رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم مكّة دخل صناديد قريش الكعبة و هم يظنّون أنّ السيف لا يرفع عنهم و أتى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم و وقف قائماً على باب الكعبة فقال: لا إله
إلّا الله وحده وحده أنجز وعده و نصر عبده و هزم الأحزاب وحده ألا إنّ كلّ مال أو مأثرة و دم يدّعى فهو تحت قدمي هاتين إلّا سدانة الكعبة و سقاية الحاجّ فإنهما مردودتان إلى أهليهما، ألا إنّ مكّة محرّمة بتحريم الله لم تحلّ لأحد كان قبلي و لم تحلّ لي إلّا ساعة من نهار و هي محرّمة إلى أن تقوم الساعة لا يختلى خلاها، و لا يقطع شجرها و لا ينفر صيدها، و لا تحلّ لقطتها إلّا لمنشد.
ثمّ قال: ألا لبئس جيران النبيّ كنتم لقد كذّبتم و طردتم و أخرجتم و آذيتم ثمّ ما رضيتم حتّى جئتموني في بلادي تقاتلونني فاذهبوا فأنتم الطلقاء فخرج القوم فكأنّما اُنشروا من القبور و دخلوا في الإسلام، و كان الله سبحانه أمكنه من رقابهم عنوة فكانوا له فيئا فلذلك سمّي أهل مكّة الطلقاء.
و جاء ابن الزبعري إلى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم و أسلم و قال:
يا رسول الإله إن لساني |
راتق ما فتقت إذ أنا بور(1) |
|
إذ أباري(2) الشيطان في سنن(3) |
الغي و من مال ميله مثبور |
|
آمن اللحم و العظام لربي |
ثم نفسي الشهيد أنت النذير |
قال: و عن ابن مسعود قال: دخل النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم يوم الفتح و حول البيت ثلاثمائة و ستون صنما فجعل يطعنها بعود في يده و يقول:( جاءَ الْحَقُّ وَ ما يُبْدِئُ الْباطِلُ وَ ما يُعِيدُ جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً ) .
و عن ابن عبّاس قال: لمّا قدم النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم إلى مكّة أبى أن يدخل البيت و فيه الآلهة فأمر بها فاُخرجت و صورة إبراهيم و إسماعيلعليهماالسلام و في أيديهما الأزلام فقالصلىاللهعليهوآلهوسلم قاتلهم الله أمّا و الله لقد علموا أنّهما لم يستقسما بها قطّ.
أقول: و الروايات حول قصّة الفتح كثيرة من أراد استقصاءها فعليه بكتب السير و جوامع الأخبار و ما تقدّم كالملخّص منها.
____________________
(1) البور: الهالك.
(2) المباراة: المباهاة.
(3) السنن: وسط الطريق.
( سورة تبّت مكّيّة و هي خمس آيات)
( سورة المسد الآيات 1 - 5)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ( 1 ) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ( 2 ) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ( 3 ) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ( 4 ) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ( 5 )
( بيان)
وعيد شديد لأبي لهب بهلاك نفسه و عمله و بنار جهنّم و لامرأته، و السورة مكّيّة.
قوله تعالى: ( تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَ تَبَّ ) التبّ و التباب هو الخسران و الهلاك على ما ذكره الجوهريّ، و دوام الخسران على ما ذكره الراغب، و قيل: الخيبة، و قيل الخلوّ من كلّ خير و المعاني - كما قيل - متقاربة فيد الإنسان هي عضوه الّذي يتوصّل به إلى تحصيل مقاصده و ينسب إليه جلّ أعماله، و تباب يديه خسرانهما فيما تكتسبانه من عمل و إن شئت فقل: بطلان أعماله الّتي يعملها بهما من حيث عدم انتهائها إلى غرض مطلوب و عدم انتفاعه بشيء منها و تباب نفسه خسرانها في نفسها بحرمانها من سعادة دائمة و هو هلاكها المؤبّد.
فقوله:( تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَ تَبَّ ) أي أبولهب، دعاء عليه بهلاك نفسه و بطلان ما كان يأتيه من الأعمال لإطفاء نور النبوّة أو قضاء منه تعالى بذلك.
و أبولهب هذا هو أبولهب بن عبدالمطّلب عمّ النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم كان شديد المعاداة للنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم مصرّاً في تكذيبه مبالغاً في إيذائه بما يستطيعه من قول و فعل و هو الّذي قال للنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم : تبّاً لك لمّا دعاهم إلى الإسلام لأوّل مرة فنزلت السورة و ردّ الله التباب عليه.
و ذكر بعضهم أنّ أبالهب اسمه و إن كان في صورة الكنية، و قيل: اسمه عبدالعزّى و قيل: عبد مناف و أحسن ما قيل في ذكره في الآية بكنيته لا باسمه أنّ في ذلك تهكّماً به لأنّ أبالهب يشعر بالنسبة إلى لهب النار كما يقال أبوالخير و أبوالفضل و أبوالشرّ في النسبة إلى الخير و الفضل و الشرّ فلمّا قيل:( سَيَصْلى ناراً ذاتَ لَهَبٍ ) فهم منه أنّ قوله:( تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ ) في معنى قولنا: تبّت يدا جهنّمي يلازم لهبها.
و قيل: لم يذكر باسمه و هو عبد العزّى لأنّ عزّى اسم صنم فكره أن يعدّ بحسب اللفظ عبداً لغير الله و هو عبد الله و إن كان الاسم إنّما يقصد به المسمّى.
قوله تعالى: ( ما أَغْنى عَنْهُ مالُهُ وَ ما كَسَبَ ) ما الاُولى نافية و ما الثانية موصولة و معنى( ما كَسَبَ ) الّذي كسبه بأعماله و هو أثر أعماله أو مصدريّة و المعنى كسبه بيديه و هو عمله، و المعنى ما أغنى عنه عمله.
و معنى الآية على أيّ حال لم يدفع عنه ماله و لا عمله - أو أثر عمله - تباب نفسه و يديه الّذي كتب عليه أو دعي عليه.
قوله تعالى: ( سَيَصْلى ناراً ذاتَ لَهَبٍ ) أي سيدخل ناراً ذات لهب و هي نار جهنّم الخالدة، و في تنكير لهب تفخيم له و تهويل.
قوله تعالى: ( وَ امْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ) عطف على ضمير الفاعل المستكنّ في( سَيَصْلى ) و التقدير: و ستصلى امرأته إلخ و( حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ) بالنصب وصف مقطوع عن الوصفيّة للذمّ أي أذمّ حمّالة الحطب، و قيل: حال من( امْرَأَتُهُ ) و هو معنى لطيف على ما سيأتي.
قوله تعالى: ( فِي جِيدِها حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ) المسد حبل مفتول من الليف، و الجملة حال ثانية من امرأته.
و الظاهر أنّ المراد بالآيتين أنّها ستتمثل في النار الّتي تصلاها يوم القيامة في هيئتها الّتي كانت تتلبّس بها في الدنيا و هي أنّها كانت تحمل أغصان الشوك و غيرها تطرحها بالليل في طريق رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم تؤذيه بذلك فتعذّب بالنار و هي تحمل الحطب و في
جيدها حبل من مسد.
قال في مجمع البيان: و إذا قيل: هل كان يلزم أبالهب الإيمان بعد هذه السورة و هل كان يقدر على الإيمان و لو آمن لكان فيه تكذيب خبر الله سبحانه بأنّه سيصلى ناراً ذات لهب.
فالجواب أنّ الإيمان يلزمه لأنّ تكليف الإيمان ثابت عليه و إنّما توعّده الله بشرط أن لا يؤمن انتهى موضع الحاجة.
أقول: مبني الإشكال على الغفلة من أنّ تعلّق القضاء الحتميّ منه تعالى بفعل الإنسان الاختياريّ لا يستوجب بطلان الاختيار و اضطرار الإنسان على الفعل فإنّ الإرادة الإلهيّة - و كذا فعله تعالى - إنّما يتعلّق بفعله الاختياريّ على ما هو عليه أي أن يفعل الإنسان باختياره كذا و كذا فلو لم يقع الفعل اختياريّاً تخلّف مراده تعالى عن إرادته و هو محال و إذا كان الفعل المتعلّق للقضاء الموجب اختياريّاً كان تركه أيضاً اختياريّاً و إن كان لا يقع فافهم و قد تقدّم هذا البحث في غير موضع من المباحث السابقة.
فقد ظهر بذلك أنّ أبالهب كان في اختياره أن يؤمن و ينجو بذلك عن النار الّتي كان من المقضيّ المحتوم أن يدخلها بكفره.
و من هذا الباب الآيات النازلة في كفّار قريش أنّهم لا يؤمنون كقوله:( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ) البقرة: 6، و قوله:( لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ) يس: 7، و من هذا الباب أيضاً آيات الطبع على القلوب.
( بحث روائي)
في المجمع في قوله تعالى:( وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) عن ابن عبّاس قال: لمّا نزلت هذه الآية صعد رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم الصفا فقال: يا صباحاه فاجتمعت إليه قريش فقالوا: ما لك؟ فقال: أ رأيتكم إن أخبرتكم أنّ العدوّ مصبحكم و ممسيكم ما كنتم
تصدّقونني؟ قالوا: بلى. قال: فإنّي نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال أبولهب: تبّاً لك أ لهذا دعوتنا جميعاً؟ فأنزل الله عزّوجلّ:( تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ ) .
أقول: و رواه أيضاً في تفسير السورة عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس و لم يذكر فيه كون الدعوة عند نزول آية( وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ ) الآية.
و فيه، أيضاً عن طارق المحاربيّ قال: بينما أنا بسوق ذي المجاز إذا أنا بشابّ يقول أيّها الناس قولوا لا إله إلّا الله تفلحوا، و إذا برجل خلفه يرميه قد أدمى ساقيه و عرقوبيه و يقول: يا أيّها الناس إنّه كذّاب فلا تصدّقوه فقلت: من هذا؟ فقالوا: هو محمّد يزعم أنّه نبيّ و هذا عمّه أبولهب يزعم أنّه كذّاب.
و في قرب الإسناد، بإسناده إلى موسى بن جعفرعليهالسلام في حديث طويل يذكر فيه آيات النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: من ذلك أنّ اُمّ جميل امرأة أبي لهب أتته حين نزلت سورة تبّت و مع النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم أبوبكر بن أبي قحافة فقال: يا رسول الله هذه اُمّ جميل محفظة أي مغضبة تريدك و معها حجر تريد أن ترميك به فقالصلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّها لا تراني فقالت لأبي بكر: أين صاحبك؟ قال: حيث شاء الله قالت: جئته و لو أراه لرميته فإنّه هجاني و اللّات و العزّى إنّي لشاعرة فقال أبوبكر: يا رسول الله لم ترك؟ قالصلىاللهعليهوآلهوسلم : لا. ضرب الله بيني و بينها حجابا.
أقول: و روي ما يقرب منه بغير واحد من طرق أهل السنّة.
و في تفسير القمّيّ: في قوله تعالى:( وَ امْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ) قال: كانت اُمّ جميل بنت صخر و كانت تنمّ على رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم و تنقل أحاديثه إلى الكفّار.
( سورة الإخلاص مكّيّة و هي أربع آيات)
( سورة الإخلاص الآيات 1 - 4)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( 1 ) اللهُ الصَّمَدُ ( 2 ) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ( 3 ) وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ( 4 )
( بيان)
السورة تصفه تعالى بأحدية الذات و رجوع ما سواه إليه في جميع حوائجه الوجوديّة من دون أن يشاركه شيء لا في ذاته و لا في صفاته و لا في أفعاله، و هو التوحيد القرآني الّذي يختصّ به القرآن الكريم و يبني عليه جميع المعارف الإسلاميّة.
و قد تكاثرت الأخبار في فضل السورة حتّى ورد من طرق الفريقين أنّها تعدل ثلث القرآن كما سيجيء إن شاء الله.
و السورة تحتمل المكّيّة و المدنيّة، و الظاهر من بعض ما ورد في سبب نزولها أنّها مكّيّة.
قوله تعالى: ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) هو ضمير الشأن و القصّة يفيد الاهتمام بمضمون الجملة التالية له، و الحقّ أنّ لفظ الجلالة علم بالغلبة له تعالى بالعربيّة كما أنّ له في غيرها من اللغات اسماً خاصّاً به، و قد تقدّم بعض الكلام فيه في تفسير سورة الفاتحة.
و أحد وصف مأخوذ من الوحدة كالواحد غير أنّ الأحد إنّما يطلق على ما لا يقبل الكثرة لا خارجاً و لا ذهناً و لذلك لا يقبل العدّ و لا يدخل في العدد بخلاف الواحد فإنّ كلّ واحد له ثانياً و ثالثاً إمّا خارجاً و إمّا ذهناً بتوهّم أو بفرض العقل فيصير بانضمامه كثيراً، و أمّا الأحد فكلّ ما فرض له ثانياً كان هو هو لم يزد عليه شيء.
و اعتبر ذلك في قولك: ما جاءني من القوم أحد فإنّك تنفي به مجيء اثنين منهم و أكثر كما تنفي مجيء واحد منهم بخلاف ما لو قلت: ما جاءني واحد منهم فإنّك إنّما تنفي به مجيء واحد منهم بالعدد و لا ينافيه مجيء اثنين منهم أو أكثر، و لإفادته هذا
المعنى لا يستعمل في الإيجاب مطلقاً إلّا فيه تعالى و من لطيف البيان في هذا الباب قول عليّ عليه أفضل السلام في بعض خطبه في توحيده تعالى: كلّ مسمّى بالوحدة غيره قليل، و قد أوردنا طرفاً من كلامهعليهالسلام في التوحيد في ذيل البحث عن توحيد القرآن في الجزء السادس من الكتاب.
قوله تعالى: ( اللهُ الصَّمَدُ ) الأصل في معنى الصمد القصد أو القصد مع الاعتماد يقال: صمده يصمده صمداً من باب نصر أي قصده أو قصده معتمداً عليه، و قد فسّروا الصمد - و هو صفة - بمعاني متعدّدة مرجع أكثرها إلى أنّه السيّد المصمود إليه أي المقصود في الحوائج، و إذا اُطلق في الآية و لم يقيّد بقيد فهو المقصود في الحوائج على الإطلاق.
و إذا كان الله تعالى هو الموجد لكلّ ذي وجود ممّا سواه يحتاج إليه فيقصده كلّ ما صدق عليه أنّه شيء غيره، في ذاته و صفاته و آثاره قال تعالى:( أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ ) الأعراف: 54 و قال و أطلق:( وَ أَنَّ إِلى رَبِّكَ الْمُنْتَهى ) النجم: 42 فهو الصمد في كلّ حاجة في الوجود لا يقصد شيئاً إلّا و هو الّذي ينتهي إليه قصده و ينجح به طلبته و يقضي به حاجته.
و من هنا يظهر وجه دخول اللّام في الصمد و أنّه لإفادة الحصر فهو تعالى وحده الصمد على الإطلاق، و هذا بخلاف أحد في قوله:( اللهُ أَحَدٌ ) فإنّ أحداً بما يفيده من معنى الوحدة الخاصّة لا يطلق في الإثبات على غيره تعالى فلا حاجة فيه إلى عهد أو حصر.
و أمّا إظهار اسم الجلالة ثانياً حيث قيل:( اللهُ الصَّمَدُ ) و لم يقل: هو الصمد، و لم يقل: الله أحد صمد فالظاهر أنّ ذلك للإشارة إلى كون كلّ من الجملتين وحدها كافية في تعريفه تعالى حيث إنّ المقام مقام تعريفه تعالى بصفة تختصّ به فقيل: الله أحد الله الصمد إشارة إلى أنّ المعرفة به حاصلة سواء قيل كذا أو قيل كذا.
و الآيتان مع ذلك تصفانه تعالى بصفة الذات و صفة الفعل جميعاً فقوله:( اللهُ أَحَدٌ ) يصفه بالأحديّة الّتي هي عين الذات، و قوله:( اللهُ الصَّمَدُ ) يصفه بانتهاء كلّ شيء إليه
و هو من صفات الفعل.
و قيل: الصمد بمعنى المصمت الّذي ليس بأجوف فلا يأكل و لا يشرب و لا ينام و لا يلد و لا يولد و على هذا يكون قوله:( لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ ) تفسيراً للصمد.
قوله تعالى: ( لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ) الآيتان الكريمتان تنفيان عنه تعالى أن يلد شيئاً بتجزّيه في نفسه فينفصل عنه شيء سنخه بأيّ معنى اُريد من الانفصال و الاشتقاق كما يقول به النصارى في المسيحعليهالسلام إنّه ابن الله و كما يقول الوثنيّة في بعض آلهتهم أنّهم أبناء الله سبحانه.
و تنفيان عنه أن يكون متولّداً من شيء آخر و مشتقّاً منه بأيّ معنى اُريد من الاشتقاق كما يقول الوثنيّة ففي آلهتهم من هو إله أبو إله و من هو آلهة اُمّ إله و من هو إله ابن إله.
و تنفيان أن يكون له كفؤ يعدله في ذاته أو في فعله(1) و هو الإيجاد و التدبير و لم يقل أحد من الملّيّين و غيرهم بالكفؤ الذاتيّ بأن يقول بتعدّد واجب الوجود عزّ اسمه، و أمّا الكفؤ في فعله و هو التدبير فقد قيل به كآلهة الوثنيّة من البشر كفرعون و نمرود من المدّعين للاُلوهيّة و ملاك الكفاءة عندهم استقلال من يرون اُلوهيّته في تدبير ما فوّض إليه تدبيره كما أنّه تعالى مستقلّ في تدبير من يدبّره و هم الأرباب و الآلهة و هو ربّ الأرباب و إله الآلهة.
و في معنى كفاءة هذا النوع من الإله ما يفرض من استقلال الفعل في شيء من الممكنات فإنه كفاءة مرجعها استغناؤه عنه تعالى و هو محتاج من كلّ جهة و الآية تنفيها.
و هذه الصفات الثلاث المنفيّة و إن أمكن تفريع نفيها على صفة أحديّته تعالى بوجه لكنّ الأسبق إلى الذهن تفرّعها على صفة صمديّته.
أمّا كونه لم يلد فإنّ الولادة الّتي هي نوع من التجّزي و التبعّض بأيّ معنى
____________________
(1) لم نذكر الصفة لأنّها إمّا صفة الذات فهي عين الذات و إمّا صفة الفعل منتزعة عن الفعل، منه.
فسّرت لا تخلو من تركيب فيمن يلد، و حاجة المركّب إلى أجزائه ضروريّة و الله سبحانه صمد ينتهي إليه كلّ محتاج في حاجته و لا حاجة له، و أمّا كونه لم يولد فإنّ تولّد شيء من شيء لا يتمّ إلّا مع حاجة من المتولّد إلى ما ولد منه في وجوده و هو سبحانه صمد لا حاجة له، و أمّا أنّه لا كفؤ له فلأنّ الكفؤ سواء فرض كفواً له في ذاته أو في فعله لا تتحقّق كفاءته إلّا مع استقلاله و استغنائه عنه تعالى فيما فيه الكفاءة و الله سبحانه صمد على الإطلاق يحتاج إليه كلّ من سواه من كلّ جهة مفروضة.
فقد تبيّن أنّ ما في الآيتين من النفي متفرّع على صمديّته تعالى و مآل ما ذكر من صمديّته تعالى و ما يتفرّع عليه إلى إثبات توحّده تعالى في ذاته و صفاته و أفعاله بمعنى أنّه واحد لا يناظره شيء و لا يشبهه فذاته تعالى بذاته و لذاته من غير استناد إلى غيره و احتياج إلى من سواه و كذا صفاته و أفعاله، و ذوات من سواه و صفاتهم و أفعالهم بإفاضة منه على ما يليق بساحة كبريائه و عظمته فمحصّل السورة وصفه تعالى بأنّه أحد واحد.
و ممّا قيل في الآية أنّ المراد بالكفؤ الزوجة فإنّ زوجة الرجل كفؤه فيكون في معنى قوله:( تَعالى جَدُّ رَبِّنا مَا اتَّخَذَ صاحِبَةً ) و هو كما ترى.
( بحث روائي)
في الكافي، بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إنّ اليهود سألوا رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فقالوا: انسب لنا ربّك فلبث ثلاثاً لا يجيبهم ثمّ نزلت:( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) إلى آخرها.
أقول: و في الاحتجاج، عن العسكريعليهالسلام : أنّ السائل عبدالله بن صوريا اليهوديّ، و في بعض روايات أهل السنّة: أنّ السائل عبدالله بن سلام سألهصلىاللهعليهوآلهوسلم ذلك بمكّة ثمّ آمن و كتم إيمانه، و في بعضها أنّ اُناساً من اليهود سألوه ذلك، و في غير
واحد من رواياتهم: أنّ مشركي مكّة سألوه ذلك، و كيف كان فالمراد بالنسبة النعت و الوصف.
و في المعاني، بإسناده عن الأصبغ بن نباتة عن عليّعليهالسلام في حديث: نسبة الله عزّوجلّ قل هو الله.
و في العلل، بإسناده عن الصادقعليهالسلام في حديث المعراج: أنّ الله قال له أي للنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم : اقرأ قل هو الله أحد كما أنزلت فإنّها نسبتي و نعتي.
أقول: و روي أيضاً بإسناده إلى موسى بن جعفرعليهالسلام ما في معناه.
و في الدرّ المنثور، أخرج أبوعبيد في فضائله عن ابن عبّاس عن النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم قال قل هو الله أحد ثلث القرآن.
أقول: و قد تكاثرت الروايات من طرقهم في هذا المعنى رووه عن عدّة من الصحابة كابن عبّاس و قد مرّ و أبي الدرداء و ابن عمر و جابر و ابن مسعود و أبي سعيد الخدريّ و معاذ بن أنس و أبي أيّوب و أبي أمامة و غيرهم عن النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم ، و ورد أيضاً في عدّة من الروايات عن أئمّة أهل البيتعليهمالسلام ، و قد وجّهوا كون السورة تعدل ثلث القرآن بوجوه مختلفة أعدلها أنّ ما في القرآن من المعارف تنحلّ إلى الاُصول الثلاثة: التوحيد و النبوّة و المعاد و السورة تتضمّن واحداً من الثلاثة و هو التوحيد.
و في التوحيد، عن أميرالمؤمنينعليهالسلام : رأيت الخضرعليهالسلام في المنام قبل بدر بليلة فقلت له: علّمني شيئاً أنصر به على الأعداء فقال: قل: يا هو يا من لا هو إلّا هو فلمّا أصبحت قصصتها على رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فقال لي: يا عليّ علّمت الاسم الأعظم فكان على لساني يوم بدر.
و إنّ أميرالمؤمنينعليهالسلام قرأ قل هو الله أحد فلمّا فرغ قال: يا هو يا من لا هو إلّا هو اغفر لي و انصرني على القوم الكافرين.
و في نهج البلاغة: الأحد لا بتأويل عدد.
أقول: و رواه في التوحيد، عن الرضاعليهالسلام و لفظه: أحد لا بتأويل عدد.
و في اُصول الكافي، بإسناده عن داود بن القاسم الجعفريّ قال: قلت لأبي
جعفر الثانيعليهالسلام : ما الصمد؟ قالعليهالسلام : السيّد المصمود إليه في القليل و الكثير.
أقول: و في تفسير الصمد معان اُخر مروية عنهمعليهمالسلام فعن الباقرعليهالسلام : الصمد السيّد المطاع الّذي ليس فوقه آمر و ناه، و عن الحسينعليهالسلام : الصمد الّذي لا جوف له و الصمد الّذي لا ينام، و الصمد الّذي لم يزل و لا يزال، و عن السجّادعليهالسلام : الصمد الّذي إذا أراد شيئاً قال له: كن فيكون، و الصمد الّذي أبدع الأشياء فخلقها أضداداً و أشكالاً و أزواجاً و تفرّد بالوحدة بلا ضدّ و لا شكل و لا مثل و لا ندّ.
و الأصل في معنى الصمد هو الّذي رويناه عن أبي جعفر الثانيعليهالسلام لما في مادّته لغة في معنى القصد فالمعاني المختلفة المنقولة عنهمعليهمالسلام من التفسير يلازم المعنى فإنّ المعاني المذكورة لوازم كونه تعالى مقصوداً يرجع إليه كلّ شيء في كلّ حاجة فإليه ينتهي الكلّ من دون أن تتحقّق فيه حاجة.
و في التوحيد، عن وهب بن وهب القرشيّ عن الصادق عن آبائهعليهمالسلام أنّ أهل البصرة كتبوا إلى الحسين بن عليّعليهماالسلام يسألونه عن الصمد فكتب إليهم: بسم الله الرحمن الرحيم أمّا بعد فلا تخوضوا في القرآن و لا تجادلوا فيه و لا تتكلّموا فيه بغير علم فقد سمعت جدّي رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم يقول: من قال في القرآن بغير علم فليتبوّأ مقعده من النار، و إنّ الله سبحانه فسّر الصمد فقال: الله أحد الله الصمد ثمّ فسّره فقال: لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً أحد.
و فيه، بإسناده إلى ابن أبي عمير عن موسى بن جعفرعليهالسلام أنّه قال: و اعلم أنّ الله تعالى واحد أحد صمد لم يلد فيورث و لم يولد فيشارك.
و فيه، في خطبة اُخرى لعليّعليهالسلام : الّذي لم يولد فيكون في العزّ مشاركاً و لم يلد فيكون موروثاً هالكاً.
و فيه، في خطبة لهعليهالسلام : تعالى أن يكون له كفؤ فيشبه به.
أقول: و في المعاني المتقدّمة روايات اُخرى.
( سورة الفلق مكية و هي خمس آيات)
( سورة الفلق الآيات 1 - 5)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ( 1 ) مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ( 2 ) وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ( 3 ) وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ( 4 ) وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ( 5 )
( بيان)
أمر للنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم أن يعوذ بالله من كلّ شرّ و من بعضه خاصّة و السورة مدنيّة على ما يظهر ممّا ورد في سبب نزولها.
قوله تعالى: ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ) العوذ هو الاعتصام و التحرّز من الشرّ بالالتجاء إلى من يدفعه، و الفلق بالفتح فالسكون الشقّ و الفرق، و الفلق بفتحتين صفة مشبهة بمعنى المفعول كالقصص بمعنى المقصوص، و الغالب إطلاقه على الصبح لأنّه المشقوق من الظلام، و عليه فالمعنى أعوذ بربّ الصبح الّذي يفلقه و يشقّه و مناسبة هذا التعبير للعوذ من الشرّ الّذي يستر الخير و يحجب دونه ظاهر.
و قيل: المراد بالفلق كلّ ما يفطر و يفلق عنه بالخلق و الإيجاد فإنّ في الخلق و الإيجاد شقاً للعدم و إخراجاً للموجود إلى الوجود فيكون مساويّاً للمخلوق، و قيل هو جبّ في جهنّم و يؤيّده بعض الروايات.
قوله تعالى: ( مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ ) أي من شرّ من يحمل شرّاً من الإنس و الجنّ و الحيوانات و سائر ما له شرّ من الخلق فإنّ اشتمال مطلق ما خلق على الشرّ لا يستلزم الاستغراق.
قوله تعالى: ( وَ مِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ ) في الصحاح: الغسق أوّل ظلمة اللّيل
و قد غسق اللّيل يغسق إذا أظلم و الغاسق اللّيل إذا غاب الشفق. انتهى، و الوقوب الدخول فالمعنى و من شرّ اللّيل إذا دخل بظلمته. و نسبة الشرّ إلى اللّيل إنّما هي لكونه بظلمته يعين الشرير في شرّه لستره عليه فيقع فيه الشرّ أكثر ممّا يقع منه بالنهار، و الإنسان فيه أضعف منه في النهار تجاه هاجم الشرّ، و قيل: المراد بالغاسق كلّ هاجم يهجم بشرّه كائناً ما كان.
و ذكر شرّ اللّيل إذا دخل بعد ذكر شرّ ما خلق من ذكر الخاصّ بعد العامّ لزيادة الاهتمام و قد اهتمّ في السورة بثلاثة من أنواع الشرّ خاصّة هي شرّ اللّيل إذا دخل و شرّ سحر السحرة و شرّ الحاسد إذا حسد لغلبة الغفلة فيهنّ.
قوله تعالى: ( وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِي الْعُقَدِ ) أي النساء الساحرات اللّاتي يسحرن بالعقد على المسحور و ينفثن في العقد. و خصّت النساء بالذكر لأنّ السحر كان فيهنّ و منهم أكثر من الرجال، و في الآية تصديق لتأثير السحر في الجملة، و نظيرها قوله تعالى: في قصّة هاروت و ماروت:( فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ ما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ ) البقرة: 102 و نظيره ما في قصّة سحرة فرعون.
و قيل: المراد بالنفّاثات في العقد النساء اللّاتي يملن آراء أزواجهنّ إلى ما يرينه و يردنه فالعقد هو الرأي و النفث في العقد كناية عن حلّه، و هو بعيد.
قوله تعالى: ( وَ مِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ ) أي إذا تلبّس بالحسد و عمل بما في نفسه من الحسد بترتيب الأثر عليه.
و قيل: الآية تشمل العائن فعين العائن نوع حسد نفسانيّ يتحقّق منه إذا عاين ما يستكثره و يتعجّب منه.
( بحث روائي)
في الدرّ المنثور، أخرج عبد بن حميد عن زيد بن أسلم قال: سحر النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم رجل من اليهود فاشتكى فأتاه جبريل فنزل عليه بالمعوّذتين و قال: إنّ رجلاً من اليهود سحرك و السحر في بئر فلان فأرسل عليّاً فجاء به فأمره أن يحلّ العقد و يقرأ آية فجعل يقرأ و يحلّ حتّى قام النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم كأنّما نشط من عقال.
أقول: و عن كتاب طبّ الأئمّة، بإسناده إلى محمّد بن سنان عن المفضّل عن الصادقعليهالسلام : مثله و في هذا المعنى روايات كثيرة من طرق أهل السنّة باختلاف يسيرة، و في غير واحد منها أنّه أرسل مع عليّعليهالسلام زبيراً و عمّاراً و فيه روايات اُخرى أيضاً من طرق أئمّة أهل البيتعليهمالسلام .
و ما استشكل به بعضهم في مضمون الروايات أنّ النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم كان مصوناً من تأثير السحر كيف؟ و قد قال الله تعالى:( وَ قالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُوراً انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ) الفرقان: 9.
يدفعه أنّ مرادهم بالمسحور و المجنون بفساد العقل بالسحر و أمّا تأثّره عن السحر بمرض يصيبه في بدنه و نحوه فلا دليل على مصونيّته منه.
و في المجمع، و روي: أنّ النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم كان كثيراً ما يعوّذ الحسن و الحسينعليهماالسلام بهاتين السورتين.
و فيه، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : اُنزلت عليّ آيات لم ينزل مثلهنّ المعوّذتان، أورده في الصحيح.
أقول: و أسندها في الدرّ المنثور، إلى الترمذيّ و النسائيّ و غيرهما أيضاً، و روي ما في معناه أيضاً عن الطبرانيّ في الأوسط عن ابن مسعود، و لعلّ المراد من عدم نزول مثلهنّ أنّهما في العوذة فقط و لا يشاركهما في ذلك غيرهما من السور.
و في الدرّ المنثور، أخرج أحمد و البزّار و الطبرانيّ و ابن مردويه من طرق صحيحة
عن ابن عبّاس و ابن مسعود أنّه كان يحكّ المعوّذتين من المصحف و يقول: لا تخلطوا القرآن بما ليس منه إنّهما ليستا من كتاب الله إنّما اُمر النبيّ أن يتعوّذ بهما، و كان ابن مسعود لا يقرأ بهما.
أقول: ثمّ قال السيوطيّ قال البزّار: و لم يتابع ابن مسعود أحد من الصحابة و قد صحّ عن النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قرأ بهما في الصلاة و قد اُثبتنا في المصحف انتهى.
و في تفسير القمّيّ، بإسناده عن أبي بكر الحضرميّ قال: قلت لأبي جعفرعليهالسلام إنّ ابن مسعود كان يمحو المعوّذتين من المصحف. فقال: كان أبي يقول: إنّما فعل ذلك ابن مسعود برأيه و هو [ هما ظ ] من القرآن.
أقول: و في هذا المعنى روايات كثيرة من طرق الفريقين على أنّ هناك تواتراً قطعيّاً من عامّة المنتحلين بالإسلام على كونهما من القرآن، و قد استشكل بعض المنكرين لإعجاز القرآن أنّه لو كان معجزاً في بلاغته لم يختلف في كون السورتين من القرآن مثل ابن مسعود، و اُجيب بأنّ التواتر القطعيّ كاف في ذلك على أنّه لم ينقل عنه أحد أنّه قال بعدم نزولهما على النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم أو قال بعدم كونهما معجزتين في بلاغتهما بل قال بعدم كونهما جزء من القرآن و هو محجوج بالتواتر.
و في الدرّ المنثور، أخرج ابن جرير عن أبي هريرة عن النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: الفلق جبّ في جهنّم مغطّى.
أقول: و في معناه غير واحد من الروايات في بعضها: قالصلىاللهعليهوآلهوسلم : باب في النار إذ فتح سعّرت جهنّم: رواه عقبة بن عامر، و في بعضها: بئر في جهنّم إذا سعّرت جهنّم فمنه تسعّر، رواه عمرو بن عنبسة إلى غير ذلك.
و في المجمع، و قيل: الفلق جبّ في جهنّم يتعوّذ أهل جهنّم من شدّة حرّه: عن السدّيّ و رواه أبو حمزة الثماليّ و عليّ بن إبراهيم في تفسيرهما.
و في تفسير القمّيّ، عن أبيه عن النوفليّ عن السكوني عن أبي عبداللهعليهالسلام
قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : كاد الفقر أن يكون كفراً و كاد الحسد أن يغلب القدر.
أقول: الرواية مرويّة بلفظها عن أنس عنهصلىاللهعليهوآلهوسلم .
و في العيون، بإسناده عن السلطيّ عن الرضا عن أبيه عن آبائه عن النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: كاد الحسد أن يسبق القدر.
و في الدرّ المنثور، أخرج ابن أبي شيبة عن أنس قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّ الحسد ليأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب.
( سورة الناس مدنيّة و هي ستّ آيات)
( سورة الناس الآيات 1 - 6)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ( 1 ) مَلِكِ النَّاسِ ( 2 ) إِلَهِ النَّاسِ ( 3 ) مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ( 4 ) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ( 5 ) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ( 6 )
( بيان)
أمر للنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم أن يعوذ بالله من شرّ الوسواس الخنّاس و السورة مدنيّة كسابقتها على ما يستفاد ممّا ورد في سبب نزولها بل المستفاد من الروايات أنّ السورتين نزلتا معاً.
قوله تعالى: ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلهِ النَّاسِ ) من طبع الإنسان إذا أقبل عليه شرّ يحذره و يخافه على نفسه و أحسّ من نفسه الضعف أن يلتجئ بمن يقوى على دفعه و يكفيه وقوعه و الّذي يراه صالحاً للعوذ و الاعتصام به أحد ثلاثة إمّا ربّ يلي أمره و يدبّره و يربّيه يرجع إليه في حوائجه عامّة، و ممّا يحتاج إليه في بقائه دفع ما يهدّده من الشرّ، و هذا سبب تامّ في نفسه، و إمّا ذو قوّة و سلطان بالغة قدرته نافذ حكمه يجيره إذا استجاره فيدفع عنه الشرّ بسلطته كملك من الملوك، و هذا أيضاً سبب تامّ مستقلّ في نفسه.
و هناك سبب ثالث و هو الإله المعبود فإنّ لازم معبوديّة الإله و خاصّة إذا كان واحداً لا شريك له إخلاص العبد نفسه له فلا يدعو إلّا إيّاه و لا يرجع في شيء من حوائجه إلّا إليه فلا يريد إلّا ما أراده و لا يعمل إلّا ما يشاؤه.
و الله سبحانه ربّ الناس و ملك الناس و إله الناس كما جمع الصفات الثلاث لنفسه في قوله:( ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ) الزمر: 6 و أشار
تعالى إلى سببيّة ربوبيّته و اُلوهيّته بقوله:( رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ) المزمل: 9، و إلى سببيّة ملكه بقوله:( لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ) الحديد: 5 فإن عاذ الإنسان من شرّ يهدّده إلى ربّ فالله سبحانه هو الربّ لا ربّ سواه و إن أراد بعوذه ملكاً فالله سبحانه هو الملك الحقّ له الملك و له الحكم(1) و إن أراد لذلك إلهاً فهو الإله لا إله غيره.
فقوله تعالى:( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ) إلخ أمر لنبيّهصلىاللهعليهوآلهوسلم أن يعوذ به لأنّه من الناس و هو تعالى ربّ الناس ملك الناس إله الناس.
و ممّا تقدّم ظهر أوّلاً وجه تخصيص الصفات الثلاث: الربّ و الملك و الإله من بين سائر صفاته الكريمة بالذكر و كذا وجه ما بينها من الترتيب فذكر الربّ أوّلاً لأنّه أقرب من الإنسان و أخصّ ولاية ثمّ الملك لأنّه أبعد منالاً و أعمّ ولاية يقصده من لا وليّ له يخصّه و يكفيه ثمّ الإله لأنّه وليّ يقصده الإنسان عن إخلاصه لا عن طبعه المادّي.
و ثانياً وجه عدم وصل قوله:( مَلِكِ النَّاسِ إِلهِ النَّاسِ ) بالعطف و ذلك للإشارة إلى كون كلّ من الصفات سبباً مستقلّاً في دفع الشرّ فهو تعالى سبب مستقلّ لكونه ربّاً لكونه ملكاً لكونه إلهاً فله السببيّة بأيّ معنى اُريد السبب و قد مرّ نظير الوجه في قوله:( اللهُ أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ ) .
و بذلك يظهر أيضاً وجه تكرار لفظ الناس من غير أن يقال: ربّهم و إلههم فقد اُشير به إلى أنّ كلّاً من الصفات الثلاث يمكن أن يتعلّق بها العوذ وحدها من غير ذكر الاُخريين لاستقلالها و لله الأسماء الحسنى جميعاً، و للقوم في توجيه اختصاص هذه الصفات و سائر ما مرّ من الخصوصيّات وجوه لا تغني شيئاً.
قوله تعالى: ( مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ ) قال في المجمع: الوسواس حديث النفس بما هو كالصوت الخفيّ انتهى فهو مصدر كالوسوسة كما ذكره و ذكروا أنّه سماعيّ و القياس فيه كسر الواو كسائر المصادر من الرباعيّ المجرّد و كيف كان فالظاهر
____________________
(1) التغابن: 1.
كما استظهر أنّ المراد به المعنى الوصفيّ مبالغة، و عن بعضهم أنّه صفة لا مصدر.
و الخنّاس صيغة مبالغة من الخنوس بمعنى الاختفاء بعد الظهور قيل: سمّي الشيطان خنّاساً لأنّه يوسوس للإنسان فإذا ذكر الله تعالى رجع و تأخّر ثمّ إذا غفل عاد إلى وسوسته.
قوله تعالى: ( الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ) صفة للوسواس الخنّاس، و المراد بالصدور هي النفوس لأنّ متعلّق الوسوسة هو مبدأ الإدراك من الإنسان و هو نفسه و إنّما اُخذت الصدور مكاناً للوسواس لما أنّ الإدراك ينسب بحسب شيوع الاستعمال إلى القلب و القلب في الصدر كما قال تعالى:( وَ لكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ) الحجّ: 46.
قوله تعالى: ( مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ) بيان للوسواس الخنّاس و فيه إشارة إلى أنّ من الناس من هو ملحق بالشياطين و في زمرتهم كما قال تعالى:( شَياطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ ) الأنعام: 112.
وأمّا قيل: إنّ الناس يطلق علي جماعة الجنّ كما يطلق علي الإنس، و قوله:( مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ) بيان للناس بهذا المعني الأعمّ فتحكّم لا يصغي إليه.
وكذا ما قيل: إنّ قوله:( وَ النَّاسِ ) معطوف علي( الْوَسْواسِ ) والمعني من شرّ الوسواس الخنّاس من الجنّة و من شرّ الناس بعيد عن الفهم كما لا يخفي.
( بحث روائي)
في المجمع: أبوخديجة عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: جاء جبرئيل إلى النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم و هو شاك فرقاه بالمعوّذتين و قل هو الله أحد و قال: بسم الله أرقيك و الله يشفيك من كلّ داء يؤذيك خذها فلتهنيك فقال: بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بربّ الناس إلى آخر السورة.
أقول: و تقدّم بعض الروايات الواردة في سبب نزول السورة.
و فيه، روي عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّ الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله خنس و إذا نسي التقم فذلك الوسواس الخنّاس.
و فيه، روى العيّاشيّ بإسناده عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمّدعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : ما من مؤمن إلّا و لقلبه في صدره اُذنان اُذن ينفث فيها الملك و اُذن ينفث فيها الوسواس الخنّاس فيؤيّد الله المؤمن بالملك، و هو قوله سبحانه:( وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ) .
و في أمالي الصدوق، بإسناده إلى الصادقعليهالسلام قال: لمّا نزلت هذه الآية:( وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ) صعد إبليس جبلاً بمكّة يقال له ثوير فصرخ بأعلى صوته بعفاريته فاجتمعوا إليه فقالوا: يا سيّدنا لم دعوتنا؟ قال: نزلت هذه الآية فمن لها؟ فقام عفريت من الشياطين فقال: أنا لها بكذا و كذا. قال: لست لها فقام آخر فقال مثل ذلك فقال لست لها.
فقال الوسواس الخنّاس: أنا لها. قال: بما ذا؟ قال: أعدهم و اُمنّيهم حتّى يواقعوا الخطيئة فإذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم الاستغفار فقال: أنت لها فوكّله بها إلى يوم القيامة.
أقول: تقدّم بعض الكلام في الشيطان في أوائل الجزء الثامن من الكتاب.
* * *
تمّ الكتاب و الحمد لله و اتّفق الفراغ من تأليفه في ليلة القدر المباركة الثالثة و العشرين من ليالي شهر رمضان من شهور سنة اثنتين و تسعين و ثلاثمائة بعد الألف من الهجرة و الحمد لله على الدوام، و الصلاة على سيّدنا محمّد و آله و السلام.
الفهرس
( سورة الملك مكّيّة و هي ثلاثون آية ). 2
( سورة الملك الآيات 1 - 14 ). 2
( بيان ). 3
( بحث روائي ). 11
( سورة الملك الآيات 15 - 22 ). 13
( بيان ). 13
( بحث روائي ). 18
( سورة الملك الآيات 23 - 30 ). 19
( بيان ). 19
( سورة القلم مكّيّة و هي اثنتان و خمسون آية ) 24
( سورة القلم الآيات 1 - 33 ). 24
( بيان ). 25
( بحث روائي ). 35
( سورة القلم الآيات 34 - 52 ). 40
( بيان ). 41
( بحث روائي ). 50
( سورة الحاقّة مكّيّة و هي اثنتان و خمسون آية ) 53
( سورة الحاقّة الآيات 1 - 12 ). 53
( بيان ). 53
( بحث روائي ). 58
( سورة الحاقّة الآيات 13 - 37 ). 60
( بيان ). 61
( بحث روائي ). 66
( سورة الحاقّة الآيات 38 - 52 ). 68
( بيان ). 68
( سورة المعارج مكّيّة و هي أربع و أربعون آية ) 72
( سورة المعارج الآيات 1 - 18 ). 72
( بيان ). 72
( بحث روائي ). 79
( سورة المعارج الآيات 19 - 35 ). 81
( بيان ). 81
( بحث روائي ). 87
( سورة المعارج الآيات 36 - 44 ). 89
( بيان ). 89
( بحث روائي ). 95
( سورة نوح مكّيّة و هي ثمان و عشرون آية ) 96
( سورة نوح الآيات 1 - 24 ). 96
( بيان ). 97
( بحث روائي ). 106
( سورة نوح الآيات 25 - 28 ). 109
( بيان ). 109
( سورة الجنّ مكّيّة و هي ثمان و عشرون آية ) 111
( سورة الجنّ الآيات 1 - 17 ). 111
( بيان ). 112
( كلام في الجنّ ). 112
( بحث روائي ). 121
( سورة الجنّ الآيات 18 - 28 ). 124
( بيان ). 124
( بحث روائي ). 135
( سورة المزّمّل مكّيّة و هي عشرون آية ). 136
( سورة المزّمّل الآيات 1 - 19 ). 136
( بيان ). 137
( بحث روائي ). 148
( سورة المزّمّل آية 20 ). 152
( بيان ). 152
( بحث روائي ). 156
( سورة المدّثّر مكّيّة و هي ستّ و خمسون آية ) 158
( سورة المدّثّر الآيات 1 - 7 ). 158
( بيان ). 158
( بحث روائي ). 163
( سورة المدّثّر الآيات 8 - 31 ). 165
( بيان ). 166
( ذنابة لما تقدّم من الكلام في النفاق ). 172
( بحث روائي ). 174
( سورة المدّثّر الآيات 32 - 48 ). 177
( بيان ). 177
( سورة المدّثّر الآيات 49 - 56 ). 182
( بيان ). 182
( بحث روائي ). 185
( سورة القيامة مكّيّة و هي أربعون آية ). 188
( سورة القيامة الآيات 1 - 15 ). 188
( بيان ). 188
( بحث روائي ). 193
( سورة القيامة الآيات 16 - 40 ). 194
( بيان ). 194
( بحث روائي ). 203
( سورة الدهر مدنيّة و هي إحدى و ثلاثون آية ) 207
( سورة الإنسان الآيات 1 - 22 ). 207
( بيان ). 208
( بحث روائي ). 221
( كلام في هوية الإنسان على ما يفيده القرآن ). 230
( سورة الإنسان الآيات 23 - 31 ). 232
( بيان ). 232
( بحث روائي ). 236
( سورة المرسلات مكّيّة و هي خمسون آية ) 238
( سورة المرسلات الآيات 1 - 15 ). 238
( بيان ). 238
( كلام في إقسامه تعالى في القرآن ). 241
( بحث روائي ). 244
( سورة المرسلات الآيات 16 - 50 ). 246
( بيان ). 247
( بحث روائي ). 253
( سورة النبإ مكّيّة و هي أربعون آية ). 255
( سورة النبإ الآيات 1 - 16 ). 255
( بيان ). 255
( بحث روائي ). 261
( سورة النبإ الآيات 17 - 40 ). 263
( بيان ). 264
( كلام فيما هو الروح في القرآن ). 272
( بحث روائي ). 276
( سورة النازعات مكّيّة و هي ستّ و أربعون آية ) 278
( سورة النازعات الآيات 1 - 41 ). 278
( بيان ). 279
( كلام في أنّ الملائكة وسائط في التدبير ). 283
( بحث روائي ). 296
( سورة النازعات الآيات 42 - 46 ). 298
( بيان ). 298
( بحث روائي ). 301
( سورة عبس مكّيّة و هي اثنان و أربعون آية ) 303
( سورة عبس الآيات 1 - 16 ). 303
( بيان ). 303
( بحث روائي ). 308
( سورة عبس الآيات 17 - 42 ). 311
( بيان ). 311
( بحث روائي ). 318
( سورة التكوير مكّيّة و هي تسع و عشرون آية ) 321
( سورة التكوير الآيات 1 - 14 ). 321
( بيان ). 321
( بحث روائي ). 324
( سورة التكوير الآيات 15 - 29 ). 326
( بيان ). 326
( بحث روائي ). 332
( سورة الانفطار مكّيّة و هي تسع عشرة آية ) 334
( سورة الانفطار الآيات 1 - 19 ). 334
( بيان ). 334
( بحث روائي ). 341
( سورة المطفّفين مكّيّة أو مدنيّة و هي ستّ و ثلاثون آية ) 343
( سورة المطفّفين الآيات 1 - 21 ). 343
( بيان ). 343
( بحث روائي ). 351
( سورة المطفّفين الآيات 22 - 36 ). 353
( بيان ). 353
( بحث روائي ). 356
( سورة الانشقاق مكّيّة و هي خمس و عشرون آية ) 358
( سورة الانشقاق الآيات 1 - 25 ). 358
( بيان ). 359
( بحث روائي ). 365
( سورة البروج مكّيّة و هي اثنتان و عشرون آية ) 367
( سورة البروج الآيات 1 - 22 ). 367
( بيان ). 368
( بحث روائي ). 375
( سورة الطارق مكّيّة و هي سبع عشرة آية ) 379
( سورة الطارق الآيات 1 - 17 ). 379
( بيان ). 379
( بحث روائي ). 383
( سورة الأعلى مكّيّة و هي تسع عشرة آية ) 386
( سورة الأعلى الآيات 1 - 19 ). 386
( بيان ). 386
( بحث روائي ). 394
( سورة الغاشية مكّيّة و هي ستّ و عشرون آية ) 397
( سورة الغاشية الآيات 1 - 26 ). 397
( بيان ). 397
( بحث روائي ). 402
( سورة الفجر مكّيّة و هي ثلاثون آية ). 404
( سورة الفجر الآيات 1 - 30 ). 404
( بيان ). 405
( بحث روائي ). 414
( سورة البلد مكّيّة و هي عشرون آية ). 417
( سورة البلد الآيات 1 - 20 ). 417
( بيان ). 417
( بحث روائي ). 423
( سورة الشمس مكّيّة و هي خمس عشرة آية ) 426
( سورة الشمس الآيات 1 - 15 ). 426
( بيان ). 426
( بحث روائي ). 431
( سورة الليل مكّيّة و هي إحدى و عشرون آية ) 433
( سورة الليل الآيات 1 - 21 ). 433
( بيان ). 433
( بحث روائي ). 440
( سورة الضحى مكّيّة أو مدنيّة و هي إحدى عشرة آية ) 443
( سورة الضحى الآيات 1 - 11 ). 443
( بيان ). 443
( بحث روائي ). 445
( سورة أ لم نشرح مكّيّة أو مدنيّة و هي ثمان آيات ) 448
( سورة الشرح الآيات 1 - 8 ). 448
( بيان ). 448
( بحث روائي ). 452
( سورة التين مكّيّة و هي ثمان آيات ). 454
( سورة التين الآيات 1 - 8 ). 454
( بيان ). 454
( بحث روائي ). 458
( سورة العلق مكّيّة و هي تسع عشرة آية ) 459
( سورة العلق الآيات 1 - 19 ). 459
( بيان ). 459
( بحث روائي ). 465
( سورة القدر مكّيّة و هي خمس آيات ). 469
( سورة القدر الآيات 1 - 5 ). 469
( بيان ). 469
( بحث روائي ). 473
( سورة البيّنة مدنيّة و هي ثمان آيات ). 476
( سورة البيّنة الآيات 1 - 8 ). 476
( بيان ). 476
( بحث روائي ). 482
( سورة الزلزال مدنيّة و هي ثمان آيات ). 484
( سورة الزلزلة الآيات 1 - 8 ). 484
( بيان ). 484
( بحث روائي ). 486
( سورة العاديات مدنيّة و هي إحدى عشرة آية ) 488
( سورة العاديات الآيات 1 - 11 ). 488
( بيان ). 488
( بحث روائي ). 491
( سورة القارعة مكّيّة و هي إحدى عشرة آية ) 492
( سورة القارعة الآيات 1 - 11 ). 492
( بيان ). 492
( بحث روائي ). 494
( سورة التكاثر مكّيّة و هي ثمان آيات ). 495
( سورة التكاثر الآيات 1 - 8 ). 495
( بيان ). 495
( بحث روائي ). 498
( سورة العصر مكّيّة و هي ثلاث آيات ). 501
( سورة العصر الآيات 1 - 3 ). 501
( بيان ). 501
( بحث روائي ). 504
( سورة الهمزة مكّيّة و هي تسع آيات ). 505
( سورة الهمزة الآيات 1 - 9 ). 505
( بيان ). 505
( بحث روائي ). 507
( سورة الفيل مكّيّة و هي خمس آيات ). 509
( سورة الفيل الآيات 1 - 5 ). 509
( بيان ). 509
( بحث روائي ). 510
( سورة قريش مكّيّة و هي أربع آيات ). 513
( سورة قريش الآيات 1 - 4 ). 513
( بيان ). 513
( بحث روائي ). 516
( سورة الماعون مدنيّة أو مكّيّة و هي سبع آيات ) 518
( سورة الماعون الآيات 1 - 7 ). 518
( بيان ). 518
( بحث روائي ). 519
( سورة الكوثر مكّيّة و هي ثلاث آيات ). 521
( سورة الكوثر الآيات 1 - 3 ). 521
( بيان ). 521
( بحث روائي ). 523
( سورة الكافرون مكّيّة و هي ست آيات ) 526
( سورة الكافرون الآيات 1 - 6 ). 526
( بيان ). 526
( بحث روائي ). 528
( سورة النصر مدنيّة و هي ثلاث آيات ). 530
( سورة النصر الآيات 1 - 3 ). 530
( بيان ). 530
( بحث روائي ). 532
( سورة تبّت مكّيّة و هي خمس آيات ). 539
( سورة المسد الآيات 1 - 5 ). 539
( بيان ). 539
( بحث روائي ). 541
( سورة الإخلاص مكّيّة و هي أربع آيات ) 543
( سورة الإخلاص الآيات 1 - 4 ). 543
( بيان ). 543
( بحث روائي ). 546
( سورة الفلق مكية و هي خمس آيات ). 549
( سورة الفلق الآيات 1 - 5 ). 549
( بيان ). 549
( بحث روائي ). 551
( سورة الناس مدنيّة و هي ستّ آيات ). 554
( سورة الناس الآيات 1 - 6 ). 554
( بيان ). 554
( بحث روائي ). 556