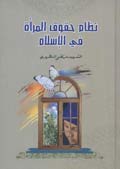نظام حقوق المرأة في الإسلام
نظام حقوق المرأة في الإسلام
الشهيد آية الله مرتضى المطهّري
بسم الله الرّحمن الرّحيم
مقدّمة المؤلِّف
تقتضي متطلّبات هذا العصر أن يعاد تقويم كثير من المسائل، وإلاّ يكتفى بالتقويمات القديمة، و(نظام الحقوق والواجبات الأُسرية) من جملة هذه المسائل.
في هذا العصر، ولأسباب سأشير إليها لاحقاً، أفترض أن تكون المسألة الأساسية في هذا الباب هي (حرية المرأة) و(حق المساواة) بين المرأة والرجل، وأنّ جميع المسائل الأُخرى متفرّعة عن هاتين المسألتين.
أمّا في نظرنا، فإنّ المسألة الأساسية في باب (نظام حقوق الأُسرة) - أو على الأقل في مرتبة المسائل الأساسية - هي أنّ نظام الأُسرة هل هو نظام مستقل عن باقي النظم الاجتماعية؟ وهل هو معيار خاص به يختلف عن المعايير المتبعة في سائر النظم الاجتماعية؟ أم ليس هناك أي فرق بين هذه الوحدة الاجتماعية وبين سائر الوحدات الأُخرى، وهو محكوم بنفس المنطق ونفس الفلسفة ونفس المعايير التي تحكم بقيّة الوحدات الاجتماعية؟
أساس هذا التردّد هو كون ركني هذه الوحدة جنسين من جهة، وتوالي أجيال الوالدين والأبناء من جهةٍ أُخرى. وقد منح الخالق تعالى أعضاء هذه الوحدة أوضاعاً متفاوتة وغير متساوية فيما بينها وكيفيات
متباينة. ومجتمع الأُسرة مجتمع (طبيعي - وضعي) أي مجتمع وسط بين المجتمع الغريزي كمجتمع النحل والنمل الذي وضعت الطبيعة له حدوده وحقوقه ومقرّراته فلا يزيغ عنها، والمجتمع الوضعي مثل مجتمع الحضارة الإنسانية الذي يتميّز بدرجة قليلة من الطبيعية والغريزية.
وكما نعلم فإنّ قدماء الفلاسفة كانوا يعدّون فلسفة الحياة الأُسرية فرعاً مستقلاًّ من (الحكمة العملية)، ويعتقدون بمنطق ومعيار خاصّين لهذا الجانب من الحياة الإنسانية... وأنّ أفلاطون في رسالة (الجمهورية)، وأرسطو في كتاب (السياسة)، وابن سينا في كتاب (الشفاء)، قد نظروا إلى هذا الموضوع من هذه الزاوية.
وفيما يخصّ حقوق المرأة في المجتمع، هناك أيضاً تساؤل واستفهام فيما إذا كانت الحقوق الطبيعية والإنسانية للمرأة والرجل متشابهة أم غير متشابهة. أي أنّ الخلق والطبيعة التي منحت الإنسان مجموعة من الحقوق، هل جعلت هذه الحقوق جنسين أم جنساً واحداً؟ وهل وجدت (الذكورة) و(الأُنوثة) طريقها إلى الحقوق والواجبات الاجتماعية، أم أنّ الحقوق في نظر الطبيعة وفي منطق التكوين والخلق جنس واحد؟
* * *
في الغرب، منذ القرن السابع عشر وما بعده، اقترنت النهضة العلمية والفلسفية بنهضة اجتماعية وباسم (حقوق الإنسان). وقد نشط كتّاب
ومفكّروا القرنين السابع عشر والثامن عشر بنشر أفكارهم بين الناس حول الحقوق الطبيعية والفطرية - غير القابلة للسلب - للبشر، ومن بين هؤلاء الكتّاب والمفكّرين: جان جاك روسو، وفولتير، ومنتسكيو. وقد كان لهذه المجموعة من المفكّرين فضل عظيم على المجتمع البشري، وقد يمكن القول: إنّ فضل هؤلاء على المجتمع الإنساني لا يقل عن فضل المكتشفين والمخترعين الكبار.
وقد كان المبدأ الأساس الذي اعتمده هؤلاء المفكّرون هو أنّ الإنسان يستحق مجموعة من الحقوق والحرّيّات بالفطرة، وبأمر الخلق والطبيعة. هذه الحقوق والحرّيّات لا يمكن لأيّ فردٍ أو جماعة - تحت أي اسم أو عنوان - سلبها عن فرد أو جماعة آخرين، وحتى صاحب الحق نفسه ليس له - طبقاً لهواه وإرادته - أن يحرم نفسه من هذه الحقوق ويهبها لغيره. كما أنّ جميع الناس: الحاكم والمحكوم... الأبيض والأسود... الغني والفقير، يتساوون في هذه الحقوق والحرّيّات.
وقد ظهرت ثمار هذه النهضة الفكرية والاجتماعية لأوّل مرة في انكلترا، ثم في أمريكا، ثم في فرنسا (على شكل ثورات وتغيير في الأنظمة ونشر بيانات)، وانتشرت بالتدريج إلى البلدان الأخرى.
في القرن التاسع عشر، ظهرت أفكار جديدة ترتبط بحقوق الإنسان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وحدثت تحوّلات أخرى انتهت بظهور الاشتراكية ووجوب منح الأرباح إلى
الطبقات الكادحة، وانتقال الحاكم من الطبقة الرأسمالية إلى المدافعين عن الطبقة العاملة.
وحتى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، كان كل ما قيل حول حقوق الإنسان، أو ما نفذ عملياً في المجتمع هو ما يتعلّق بحقوق الشعوب مقابل حكوماتها، أو حقوق الطبقة العاملة والكادحين مقابل أصحاب العمل.
وفي القرن العشرين طُرحت مسألة (حقوق المرأة) في مقابل (حقوق الرجل) وأعلن بصراحة ولأوّل مرة - في لائحة حقوق الإنسان التي نشرتها منظمة الأُمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية عام 1948م - عن تساوي حقوق المرأة والرجل.
في جميع النهضات الاجتماعية في الغرب من القرن السابع عشر وحتى القرن الحالي، كان المحور الأساس لهذه النهضات: (التحرّر) و(المساواة) ونظراً لأنّ نهضة حقوق المرأة في الغرب جاءت في أعقاب سائر النهضات: كما أنّ تاريخ المرأة في أوروبا من ناحية الحريات والمساواة كان مشحوناً بالمرارة، ففي هذا المجال أيضاً لم تجن المرأة غير شعار (الحرية) و(المساواة).
وقد اعتبر روّاد هذه النهضة تحرّر المرأة ومساواتها بالرجل في الحقوق متمّماً لنهضة حقوق الإنسان التي بدأت في القرن السابع عشر، وادعوا أنّه بدون تأمين حرية المرأة ومساواتها في الحقوق مع الرجل
يصبح الكلام عن حرية وحقوق الإنسان بلا معنى، إضافةً إلى أنّ جميع مشاكل الأُسرة ناشئة عن عدم تحرّر المرأة وعدم مساواتها بالرجل، وبتأمين هذا الجانب تحل مشكلات الأُسرة كلها مرة واحدة.
في هذه النهضة، نسي ما كان قد اعتبرناه (المسألة الأساسية في نظام حقوق الأُسرة) وهو هل أنّ هذا النظام - بطبعه - نظام مستقل، وله منطق ومعيار مستقلاّن عن منطق ومعيار باقي المؤسّسات الاجتماعية أم لا، وإنّما الذي انصرفت إليه الأذهان هو تعميم مبدأ الحرية والمساواة على النساء في مقابل الرجال. وبتعبيرٍ آخر: في مجال حقوق المرأة كان موضوع البحث فقط (الحقوق الطبيعية والفطرية للإنسان غير القابلة للسلب) لا غير. فكانت جميع الأحاديث وهي إنسان كامل ولذا يجب أن تتمتّع - كالرجل، وفي المقابل - بالحقوق الفطرية للإنسان غير القابلة للسلب.
وقد بحثنا في بعض فصول الكتاب مسألة: (مصادر الحقوق الطبيعية) بحثاً كافياً. وأثبتنا فيها أنّ أساس الحقوق الطبيعية والفطرية هو الطبيعة نفسها. أي أنّ الإنسان كان يتمتّع بحقوق خاصة يفتقدها الحصان والخروف والدجاجة والسمكة فإنّما أساس ذلك الطبيعة والخلقة، وإذا كان الناس جميعاً متساوين في الحقوق الطبيعية ويجب أن يحيوا جميعاً (أحراراً)، فإنّما أساس ذلك أمر متوفّر في أصل الخلقة، وليس لذلك أي سبب آخر؛ والعلماء المناصرون للحرية والمساواة إنّما يطرحونها على
أنّها حقوق فطرية للناس وليس لديهم أي دليل غير ذلك، بالطبع، فإنّ المسألة لنظام الأُسرة ليس لها مرجع غير الطبيعة.
والآن يجب أن ننظر لماذا لم تحز تلك المسألة - التي سمّيناها المسألة الأساسية لنظام حقوق الأُسرة - اهتماماً كافياً؟ فهل تبيّن على ضوء العلوم العصرية أنّ تفاوت واختلاف المرأة عن الرجل هو اختلاف عضوي بسيط لا تأثير له في أساس بناء جسميهما وروحيهما، ولا في الحقوق التي يجب أن يتمتّعا بها أو المسؤوليات التي يجب أن يتعهّدا بها؟ وعلى هذا الأساس لم تفتح الفلسفة الاجتماعية الحديثة حسابين منفصلين لهما؟
ومن غرائب الصدف أنّ القضية على عكس ما ذكر، فإنّ الاختلاف بين الجنسين قد أصبح أوضح على ضوء الاكتشافات العلمية والحياتية والنفسية، وقد بحثنا ذلك في بعض فصول هذا الكتاب مستندين إلى تحقيقات علماء الأحياء والفسيولوجيين وعلماء النفس، ومع ذلك كلّه فقد أمست المسألة الأساسية مغمورة وطي النسيان، وهذا ما يثير العجب.
وقد يكون سبب هذا الانصراف عن المسألة الأساسية هو أنّ هذه النهضة تمّت بسرعة كبيرة؛ ولذلك فإنّها في الوقت الذي أنقذت المرأة من جملة تعاسات، أضافت تعاسات جديدة لها وللمجتمع البشري. وسنرى في فصول هذا الكتاب أنّ المرأة الغربية كانت حتى أوائل القرن
العشرين محرومة من أبسط الحقوق، ولم تفكّر شعوب الغرب بتلافي ذلك إلاّ في بداية هذا القرن، ولما كانت النهضة النسوية تبعاً لباقي النهضات التي قامت على أساس (الحرية) و(المساواة)، فقد طلبوا بهاتين الكلمتين جميع المعجزات، غافلين عن كون الحرية والمساواة إنّما ترتبطان بروابط البشر ببعضهم من ناحية كونهم بشراً وبتعبير أنصار (الحرية والمساواة حق للإنسان بما هو إنسان) إنّ المرأة من ناحية كونها إنساناً، قد خُلقت - ككل إنسان آخر - حرة وتتمتّع بحقوق مساوية لباقي حقوق الناس، لكن المرأة إنسان بكيفيّة خاصّة والرجل إنسان بكيفيّة أُخرى، والمرأة والرجل (متساويان) في الإنسانية لكنّهما نوعان من الإنسان، بنوعين من الخواص ونوعين من الصفات النفسية. وهذا الاختلاف ليس ناتجاً عن عوامل جغرافية أو تاريخية أو اجتماعية، إنّما مخطّط ذلك قد نُقش في أصل الخلقة. إنّ للطبيعة من وراء صنع نوعين من الإنسان هدفاً معيّناً، وكل عمل ضد الطبيعة والفطرة لابد أن يؤدّي إلى عوارض غير مرغوبة. ونحن كما استلهمنا من الطبيعة فكرة حرية الإنسان والمساواة بين الناس - بما في ذلك المرأة والرجل - كذلك يجب أن نستلهم منها درس (النوع الواحد) أو (النوعين) في حقوق المرأة والرجل، وهل أنّ مجتمع الأُسرة هو مجتمع نصف طبيعي - على الأقل - أم لا؟ وعلى الأقل فإنّ مسألة كون الحيوانات - ومنها الإنسان - جنسين هل هو من قبيل الصدفة أم ضمن مخطّط الخلقة، مسألة تستحق البحث. وهل اختلاف هذين الجنسين اختلاف سطحي وعضوي أم كما
يقول الكسيس كارل إنّ كل خلية من خلايا الإنسان تحمل علامة جنسية؟ وهل في منطق ولغة الفطرة أن يحمل كل من المرأة والرجل رسالة خاصة به أم لا؟ والحقوق هل هي نوع واحد أم نوعان؟ وهل الأخلاق والتربية جنسان أم جنس واحد؟ وماذا عن العقوبات وكذلك المسؤوليات والرسالات؟
في هذه النهضة لم يلتفت إلى أنّ هناك مسائل أخرى مؤثّرة، غير الحرية والمساواة، الحرية والمساواة شرطان لازمان لا كافيان، فتساوي الحقوق شيء وتشابهها شيء آخر، وتساوي حقوق المرأة والرجل من حيث القيمة المادية والمعنوية شيء والتشابه والتماثل شيء آخر.
في هذه النهضة: حل (التساوي) محل (التشابه) و(المساواة) محل (التماثل).
واختفت (الكيفية) في ظل (الكمية).
كون المرأة (إنساناً) أدّى إلى نسيان كونها (امرأة).
والحقيقة أنّ هذا الإهمال لا يعزى إلى غفلة فلسفية ناشئة عن العجلة، بل هناك عوامل أخرى أيضاً مؤثّرة تتعلّق بالرغبة في استثمار عنوان (الحرية) و(المساواة) للمرأة.
من هذه العوامل: مطامع الرأسماليين، فأصحاب المعامل من أجل اجتذاب المرأة من البيت إلى المعمل واستثمار طاقاتها اقتصادياً، رفعوا شعارات: حقوق المرأة، الاستقلال الاقتصادي للمرأة، حرية المرأة،
مساواة المرأة بالرجل في الحقوق. وكان هؤلاء الرأسمالييون هم الذين جعلوا لهذه الشعارات: الصفة الرسمية القانونية.
ويل ديورانت - في الفصل التاسع من كتاب لذات الفلسفة - بعد أن يذكر بعض الآراء التي تحتقر المرأة عن أرسطو ونيتشه وشوبنهاور وبعض الكتب اليهودية المقدّسة، والإشارة إلى أنّ الثورة الفرنسية بالرغم من حديثها عن تحرّر المرأة، إلاّ أنّ تغيّراً عملياً لم يحدث، يقول: (حتى حدود عام 1900م لم يكن القانون ليجبر الرجل على احترام المرأة) وعندها يتطرّق إلى أسباب تغيّر وضع المرأة في القرن العشرين، فيقول: (تحرّر المرأة من آثار الثورة الصناعية) ويكمل حديثه قائلاً:
(.... كانت العاملات أقل أجراً من العمّال، وكان أصحاب المعامل يفضّلونهن على الرجال لثكرة تمرّدهم. قبل قرن من الزمان كان الحصول على عمل في انكلترا أمراً عسيراً على الرجال لكن الإعلانات كانت تدعوا الرجال إلى إرسال نسائهم وأطفالهم إلى المعامل... وكانت أوّل خطوة على طريق تحرير جداتنا تتمثّل في قانون عام 1882م إذ بموجب هذا القانون أصبحت نساء بريطانيا العظمى يتمتّعن بميزة لم يسبق لها مثيل هي أنّ من حقّهن الاحتفاظ لأنفسهن بالمال الذي يكتسبنه(1) .
هذا القانون المسيحي الأخلاقي وضعه أصحاب المعامل
____________________
(1) في شرح القانون المدني الإيراني، ص: 366 يقول الدكتور على شايغان: (إنّ الاستقلال الذي تتمتّع به المرأة في أموالها والذي اعترف به فقه الشيعة من البداية، =
في مجلس العموم من أجل أن يجتذبوا نساء انكلترا إلى المعامل. ومنذ ذلك العام وحتى العام الحالي أدّى البحث عن الربح الذي لا يقاوم إلى أن تتحرّر النساء من العذاب والاستعباد في البيت، لتصبح رهن العذاب في المتجر والمعمل....)(1) .
إنّ تكامل الآلة، والزيادة اليومية للإنتاج فوق ما يحتاجه واقع الإنسان والرغبة في استنزاف المستهلك بألف حجّة وحيلة، واستعمال الوسائل السمعية والبصرية والفكرية والشعورية والذوقية والفنيّة والشهوانية من أجل صنع إنسان مستهلك بلا إرادة، أدّت مرةً أخرى إلى أن تحتاج الرأسمالية إلى جهود المرأة، ولكن هذه المرّة لم تكن الحاجة إلى قدرتها البدنية وطاقتها الإنتاجية وجمالها وتخلّيها عن شرفها وكرامتها، وإلى قدرتها السحرية على تسخير الفكر والإرادة واستثمارهما في فرض السلع على المستهلك، وبديهي أنّ عنوان ذلك
____________________
= لم يكن موجوداً في اليونان، ولا روما ولا ألمانيا، ولا حتى وقت قريب في أغلب بلدان العالم، أي أنّها كانت محجوراً عليها مثل الصغير والمجنون ولا يحق لها التصرّف في أموالها، وفي بريطانيا حيث كانت شخصية المرأة سابقاً محجوبة بشخصية زوجها وقد رفع الحجر عنها بقانون عام 1870م وقانون 1882م باسم قانون الملكية.
(1) لذات الفلسفة: ص 155 - 159.
كلّه الحرية والمساواة مع الرجل.
والسياسة بدورها لم تكن غافلة عن استعمال هذا العمل، فأنت تقرأ أخبار الجرائد والمجلاّت، وفي جميع ذلك يستفاد من وجود المرأة؛ حتى غدت المرأة أداة لتنفيذ مآرب الرجل تحت ستار الحرية والمساواة.
وبديهي أنّ شباب القرن العشرين لم يغفل عن اغتنام هذه الفرصة الثمينة، من أجل أن يتخلّص من الالتزامات التقليدية تجاه المرأة عند الزواج، ويصطادها حيثما شاء رخيصة أو بالمجّان، ففاق الجميع في ذرف دموع التماسيح حزناً وأسفاً على تعاسة بصورة أفضل في هذا الجهاد المقدّس! أخر سن زواجه إلى الأربعين وأحياناً بقي أعزب طول حياته!!!
لا شك في أنّ القرن الأخير هذا قد خلّص المرأة من مجموعة تعاسات، ولكنّ الحديث في أنّه قد جاءها بمجموعة من التعاسات، لماذا؟ وهل أنّ المرأة محكومة بإحدى التعاستين ولابد لها قسراً أن تختار إحداهما؟ أم ليس هناك مانع من أن تقوم المرأة بطرد مصائبها القديمة والجديدة معاً؟
هذه هي الحقيقة، وهي ألاّ جبر في الموضوع، فالمصائب القديمة كانت غالباً نتيجة نسيان إنسانية المرأة، أما الجديدة فناتجة عن أنّهم
أغفلوا عمداً أو سهواً كونها امرأة، كما أغفلوا موقفها الطبيعي والفطري ورسالتها ومدارها وحاجاتها الغريزية واستعداداتها الخاصة.
العجيب أنّه حين يجري الحديث عن الاختلافات الفطرية بين المرأة والرجل يتلقّاه البعض على أنّه نقص المرأة وكمال الرجل ويؤدّي بالتالي إلى سلسلة من الحقوق بالنسبة للرجل وسلسلة من الحقوق المهدورة بالنسبة للمرأة، غافلين عن أنّ المسألة ليست مسألة نقص وكمال، فإنّ الخالق لم يرد بهذه الاختلافات أن يجعل أحدهما ناقصاً والثاني كاملاً، وبالتالي يكون أحدهما ذا حقوق وامتيازات والثاني محروماً.
هذا البعض - بعد ردّ فعله المنطقي والحكيم! - يقول: حسناً، إذا كانت طبيعة المرأة قد ظلمتها وجعلتها ضعيفة وناقصة، أيحسن أن نأتي نحن أيضاً لنزيد في مظلوميّتها؟ فإذا نسينا أو تناسينا وضع المرأة الطبيعي ألاّ نكون قد أدّينا عملاً إنسانياً لها؟
لكن الحق أنّ العكس هو الصحيح، فإنّ إهمال الوضع الطبيعي والفطري يؤدّي إلى إهدار حقوقها أكثر فأكثر، فلو أنّ الرجل أقام جبهة ضدّ المرأة فقال لها: أنتِ فرد وأنا فرد، فيجب إذاً أن تتشابه الأعمال والمسؤوليات والأرباح والأُجور والجزاء، ويجب أن تشاركيني الأعمال صعبها وثقيلها على السواء، فتأخذي أجركِ بمستوى عملكِ لا تنتظري منّي احتراماً ولا دفاعاً عنكِ، وعليكِ أن تتكلّفي جميع
مصروفاتك وتشاركيني في نفقة أطفالنا، وتدفعي عن نفسك الأخطار، وتنفقي عليّ بمقدار ما أنفق عليكِ من مال؛ في هذه الحالة تكون المرأة في وضع لا تُحسد عليه.
ذلك أنّ طاقة المرأة وإنتاجها بالطبع أقل من الرجل، واستهلاكها للثروة أكثر منه، علاوة على مرضها الشهري، وصعوبات أيام الحمل والولادة وحضانة الرضيع، ممّا يجعل المرأة محتاجة إلى حماية الرجل وأن تكون مسؤوليّاتها أقلّ وحقوقها أكثر. وهذا لا يخص الإنسان وحده، فكل الحيوانات التي تحيا حياةً زوجيّة هكذا، ففي جميع أنواع الأحياء، يبادر الذكر إلى رعاية الأُنثى بحكم الغريزة.
فإذا أخذنا بنظر الاعتبار الوضع الطبيعي والفطري لكل من المرأة والرجل مع التأكيد على تساويهما في الإنسانية والحقوق المشتركة للإنسان، لوجدنا أنّ الفطرة قد وضعت المرأة في موقع مناسب لها جداً لا يدكّ شخصها ولا شخصيّتها.
ومن أجل أن نطّلع قليلاً على النتائج العملية التي قاد إليها نسيان الموقع الطبيعي والفطري لكل من المرأة والرجل والاعتماد فقط على الحرية والمساواة، فمن الأفضل أن ننظر إلى الذين ساروا قبلنا على هذا الطريق ووصلوا إلى نهايته ماذا يقولون وماذا يكتبون؟
في مجلة (مختارات للقراء) العدد 79، السنة 34، الصادر في
4 / تير سنة 1353 هـ ش(1) نشرت مقالة من المجلة الشهرية للشرطة تحت عنوان (قصص عن النساء العاملات في المجتمع الأمريكي). وهي مقالة مترجمة من مجلة كورونت، هذه المقالة مفصّلة وتستحق القراءة، في البداية تعرض المقالة شكوى إحدى السيّدات العاملات التي تتحدث كيف أنّه باسم المساواة بين المرأة والرجل، حُرمت المرأة العاملة من العناية التي كانوا يحيطونها بها سابقاً. فمثلاً (لا ترفع المرأة حملاً يزيد وزنه على (25 ) رطلاً، بينما لا توجد مثل هذه الميزات بالنسبة للرجل)، فتقول: (تغيّرت في الوقت الحاضر ظروف العمل في معمل جنرال موتورز في ولاية أوهايو أو بتعبير آخر المكان الذي تتعذّب فيه ما يقارب الـ (2500 ) امرأة... وترى هذه السيدة نفسها أمام ماكنة جبّارة أو منهمكة بتنظيف فرن معدني زنته (25 ) رطلاً كان قد وضعه في مكانه قبل لحظات رجل مفتول العضلات وتقول في نفسها: أجد جسمي محطّماً مليئاً بالكدمات والجروح) وأضافت: (يجب عليّ في كل دقيقة أن أعلق بالرافعة حزمة ذات (25 -50 ) إنجاً يزيد وزنها على (35 ) رطلاً، وأجد يدي على الدوام متورّمتين وتؤلماني كثيراً).
ثم تنتقل المجلة إلى عرض شكاوى وقلق سيدة أُخرى يعمل زوجها بحّاراً لدى القوّة البحرية، وكانت قيادة القوّة البحرية قد صمّمت
____________________
(1) المصادف 7 حزيران (يونيو) عام 1974م. والتاريخ المذكور أعلاه هو التاريخ الهجري الشمسي.
أخيراً على استخدام عدد من النساء في السفن التي يعمل عليها الرجال. فتقول: (إنّ القوّة البحرية أرسلت في هذه الأثناء سفينة في مهمّة، شاركت فيها أربعون امرأة وأربعمئة وثمانون بحّاراً. لكن عندما عادت هذه السفينة من أوّل سفرة (مختلطة) لها، تأكّدت مخاوف وتوجّسات زوجات البحّارة؛ إذ تبيّن أنّه لم تجر قصص عشق كثيرة على السفينة فحسب، بل إنّ أغلب النساء قد مارسن الجنس ليس مع بحّار واحد فقط، بل مع عدّة منهم).
وتقول أيضاً: (في ولاية فلوريد!)، وبعد التحرّي - امتد النزاع حتى شمل (الأرامل) فقد أعلن أحد قضاة هذه الولاية واسمه (توماس تستا) عدم شرعية المادة القانونية التي تعفي الأرامل اللاتي يملكن (500) دولار فما دون من ضريبة الدخل، قائلاً إنّ هذا القانون تحيّز للنساء ضد الرجال).
ثم تضيف المجلة: (إنّ السيدة ماك دانيل تعاني من حرقة الكفين، والسيدة استون (زوجة أحد البحارة) أصبحت فريسة الاضطراب والقلق، وأرامل فلوريدا يدفعن الغرامات النقدية، والباقون أيضاً سيذوق كل واحد منهم طعم الحرية حسب إمكانه.
ويخطر سؤال على بال الكثيرين هو: ألم تخسر السيدات أكثر ممّا كنّ يتمتعن به من الحقوق؟
لكن لا فائدة الآن من هذا التساؤل والبحث؛ فإنّ اللعبة قد بدأت فعلاً واتخذ المتفرّجون أماكنهم أمام الملعب، وقد تمّت المصادقة هذا العام على سبع وعشرين مادة معدّلة في الدستور الأمريكي، وقد اعتبرت بموجب ذلك جميع الامتيازات المتعلّقة بجنس الفرد غير قانونية...
وعلى هذا فقد تحقّقت نبوءة (رسكوباوند) أُستاذ كلية الحقوق في هارفارد إذ قال: (إنّ تحرير النساء بداية لنتائج مؤسفة للمكانة القانونية للمرأة في أمريكا).
... وقد اقترح السناتور (جي اروين) من ولاية كارولينا الشمالية بعد دراسة المجتمع الأمريكي (تساوي الحقوق بين النساء والرجال.... فجميع قوانين الأُسرة يجب أن تتغيّر، ولا يكون الرجال بعد ذلك مسؤولين عن تأمين ميزانية الأُسرة).
وتكتب المجلّة: (تقول السيدة ماك دانيل: (إنّ إحدى النساء أُصيبت بنزف داخلي من جرّاء حمل بعض الأثقال. إنّنا نريد العودة إلى الوضع السابق، نرغب في أن يعاملنا الرجال على أنّنا نساء لا عمّال. أمّا بالنسبة لأنصار تحرّر المرأة فهذا الموضوع سهل جداً، إذ يجلسون في غرفة فخمة ليقولوا: (يجب أن يتساوى النساء بالرجال)؛ ذلك أنّهم لم يعرفوا العمل في المعمل بعد. إنّهم يجهلون أن جميع العاملات بأجر في هذه البلاد يعملن مثلي ويشقين في المعامل. إنّني لا أريد هذه المساواة، إذ أنّني لا أستطيع إنجاز أعمال الرجال. إنّ الرجال أقوى منّا أجساماً وإذا كان المطلوب أن ننافسهم في العمل والإنتاج ويقاس عملنا بأعمالهم فإنّني - من جانبي - أُفضّل الاعتزال. إنّ الميزات التي خسرتها عاملات ولاية أوهايو أكثر بكثير من المزايا التي كسبتها عن طريق قانون حماية العمّال. لقد خسرنا شخصيتنا النسائية. إنّني لا أفهم ماذا
استفدنا منذ الوقت الذي صرنا فيه أحراراً ولحدّ الآن؟ هناك بالطبع عدد من النساء محدود استفدن من ذلك، لكنّنا بالطبع لسنا من أُولئك).
كانت هذه خلاصة تلك المقالة. وقد تبيّن من محتواها أنّ هؤلاء النسوة - بسبب المشاكل التي واجهنها باسم الحرية والمساواة - مللن هاتين الكلمتين حتى عدن عدوات لهما، في الوقت الذي ليس لهاتين الكلمتين دخل فيما حصل. فإنّ المرأة والرجل كوكبان يدوران في مدارين مختلفين فيجب ألاّ يخرّا عن مداريهما( لاَ الشّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ اللّيْلُ سَابِقُ النّهَارِ وَكُلّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ) فالشرط الأساس لسعادة كل من المرأة والرجل - وفي الحقيقة المجتمع الإنساني - هو أن يدور كل جنس في مداره الخاص به. وحينذاك يتحقّق النفع من الحرية والمساواة حيث لم يخرج أيّ منهما عن مداره ومساره الطبيعي والفطري. فإنّ الذي خلق المشاكل للمجتمع إنّما هو التمرّد على أمر الفطرة الطبيعية ولا شيء غير ذلك.
وما ندّعيه الآن هو أنّ (النظام الحقوقي للمرأة في البيت والمجتمع) من المسائل التي يجب أن يعاد تقويمها، ولا يكتفى بالتقويمات القديمة؛ وذلك يعني أنّ: أوّلاً: نتخذ من الطبيعية هاديا لنا، ثانياً: نستفيد إلى أقصى حدٍّ ممكنٍ من مجموع التجارب السابقة والحالية (حلوها ومرّها) وعندها فقط تكون نهضة المرأة قد تحققت بالمعنى والواقعي.
* * *
القرآن الكريم - باتفاق الصديق والعدو - هو الذي أحيا حقوق المرأة. فالأعداء قد شهدوا على الأقل أنّ القرآن في عصر نزوله قه خطا خطوات كبيرة لصالح المرأة وحقوقها الإنسانية. لكن القرآن لم ينس كون المرأة امرأة ولا الرجل رجلاً حين دعا إلى إحياء (إنسانية) المرأة ومشاركتها للرجل في الإنسانية وحقوق الإنسان. وبتعبيرٍ آخر إنّ القرآن نظر إلى المرأة كما نظرت إليها الطبيعة، ومن هذه الناحية نجد الانسجام الكامل بين أوامر القرآن وأوامر الطبيعة. المرأة في القرآن هي نفس المرأة في الطبيعة. إنّ هذين الكتابين الإلهيّين الكبيرين - أحدهما تكويني والآخر تدويني - متطابقان مع بعضهما. وفي سلسلة المقالات هذه، إذا كان هناك من أمر مفيد وجديد فهو توضيح هذا التطابق والانسجام.
إنّ هذا الذي أمام القارئ المحترم، هو مجموعة مقالات كتبتها بمناسبة خاصة في سنتي 45 - 46 (1) هجرى شمسي في مجلة (زن روز) أي (امرأة اليوم) تحت عنوان (زن در حقوق إسلام) أي (المرأة في القانون الإسلامي) وحازت على اهتمام القرّاء.
وبالنسبة للأشخاص الذين لم يعايشوا الظروف آنذاك والذين يسمعون الآن أنّ هذه المقالات قد نُشرت لأوّل مرّة في هذه المجلة سيعجبون من اختياري لهذه المجلة بالذات لنشر مقالاتي، وكيف أنّ المجلة كانت
____________________
(1) تصادف عام 1966 - 1967م.
مستعدة لنشرها دون تغيير، لهذه أرى أن أسرد قصة هذه المقالات:
في سنة 45، ارتفعت حمّى تغيير القوانين المدنية فيما يخص حقوق الأُسرة في جميع المجلات خصوصاً المجلات النسائية. ونظراً لكون أكثر الاقتراحات المطروحة كانت مخالفة لصريح نصوص القرآن، فقد أوجدت حالة عدم ارتياح لدى مسلمي إيران. وفي هذه الأثناء، كان القاضي الفقيد إبراهيم المهدوي الزنجاني - عفا الله عنه - يثير الغبار أكثر من غيره ويظهر الحماس الشديد لهذا الموضوع. وقد نشر المشار إليه لائحة من أربعين بهذا الخصوص في المجلة المذكورة. وقد طبعت المجلة أيضاً قسائم، وطلبت من قرائها أن يدونوا آراءهم حول اللائحة. وقد وعد الرجل بالدفاع عن لائحه بالأدلة والبراهين في سلسلة من المقالات تنشرها المجلة المذكورة.
في تلك الأيام اتصل بي تلفونياً أحد علماء طهران المحترمين المشهورين وأخبرني أنّه قد جمعه مجلس لمديري مؤسّسة كيهان واطلاعات وأنّه قد أبدى ملاحظات حول ما كان ينشر في تلك الأيام في المجلات النسائية التي تصدرها هاتان المؤسستان. وقد أجاب الرجلان بأنّهما مستعدان لنشر أية ملاحظات حول هذه المواضيع في نفس المجلات.
وبعد أن نقل لي هذه القصة، اقترح عليّ هذا الرجل الكريم أن أطّلع على هذه المجلات إذا سنحت الفرصة، وأكتب الملاحظات اللازمة في
كل مرة. لكنّني أخبرته بأنّني غير مستعد لكتابة حاشية على ما ينشر في كل عدد، لكن بما أنّ السيد المهدوي سيقوم بنشر سلسلة من المقالات في الدفاع عن مقترح الأربعين مادة في مجلة (زن روز) أي (امرأة اليوم) فأنا على استعداد لنشر سلسلة مقالات حول الأربعين مادة نفسها في نفس المجلة على الصفحة المقابلة لكي تعرض أدلة الطرفين على الجمهور. فطلب منّي العالم أن أترك له فرصة الاتصال بمسؤولي المجلة مرّةً ثانية، ثم اتصل بي مرة أخرى وأعلمني بموافقة المجلة على نشر ما ذكر بالطريقة المقترحة، بعد ذلك كتبت رسالة إلى المجلة أعلمتها فيها باستعدادي للدفاع عن القوانين المدنية في حدود ما يطابق الفقه الإسلامي، وطلبت أن تنشر مقالاتي مقابل مقالات السيد المهدوي في المجلة المذكورة. وأشرت إلى أنّ المجلة إذا كانت توافق على اقتراحي، فلتنشر نفس الرسالة هذه كدليل على الموافقة. وقد وافقت المجلة ونشرت رسالتي في العدد 87 في 7/8/45هـ ش (1) ونشرت أول مقالة في العدد 88.
وكنت قبل ذلك قد طالعت فيما يخص حقوق المرأة كتاباً للفقيد المهدوي وعرفت منطقة ومنطق أمثاله. وعلاوة على ذلك، فإنّني منذ سنوات مهتم بحقوق المرأة في الإسلام، وقد كتبت ملاحظات كثيرة حول هذا الموضوع، وقد نشرت مقالات الفقيد المهدوي ونشرت
____________________
(1) 29 أكتوبر (تشرين الأول) / 1966م.
قبالتها مقالاتي هذه. وقد بدأت طبعاً بالموضوع الذي بدأ هو به مقالاته. لكن كتابة هذه السلسلة من المقالات أرهقت الرجل إذ لم تمر ستة أسابيع حتى توفّي بالسكتة القلبية وارتاح من المقالات إلى الأبد. خلال هذه الأسابيع الستة كانت مقالاتي قد فتحت الطريق لنفسها؛ فقد طلب المهتمون من القرّاء منّي ومن المجلة أن تستمر هذه المقالات بصورة مستقلّة، ووافقت المجلة كما وافقت أنا واستمرّت حتى وصل عددها إلى 33 مقالة. كان هذا هو سبب تحرير هذه المقالات.
صحيح أنّ ما جاء في هذه الـ 33 مقالة كان جزءاً ممّا كان يجب أن يكتب وقد بقيت مطالب كثيرة لم تكتب، إلاّ أنّني - لكثرة المشاغل والمتاعب - لم أتمكّن من أعدادها وقد طالب المهتمون منذ نشر هذه المقالات وحتى الآن عدّة مرات أن تنشر في كتاب مستقل، لكنّني كنت أؤخّر ذلك انتظاراً لإكمالها وطبعها كموضوع متكامل بعنوان (نظام حقوق المرأة في الإسلام) ولكنّني لما شعرت أخيراً ألاّ داعي للانتظار، قنعت بما كتبت وطبعته.
إنّ المسائل التي طُرحت في هذه المقالات هي عبارة عن: الخطبة، والزواج الموقت (المتعة)، والمرأة والاستقلال الاجتماعي، والإسلام وتجدّد الحياة، ومكانة المرأة في القرآن، والكرامة وحقوق الإنسان، والأُسس الطبيعية لحقوق الأُسرة، والفوارق بين المرأة والرجل، والمهر، والنفقة، والإرث، والطلاق، وتعدّد الزوجات.
أمّا المسائل الباقية والجاهزة كتابة، فعبارة عن: حق حكم الرجل في الأُسرة، حق حضانة الطفل، والعدّة وفلسفتها، والمرأة والاجتهاد والإفتاء، والمرأة والسياسة، والمرأة في قرارات القضاء، والمرأة في قرارات الجزاء، والأخلاق وتربية المرأة، ولباس المرأة، والأخلاق الجنسية: الغيرة، العفاف، الحياء، وغير ذلك. ومقام الأُمومة، والمرأة والعمل في الخارج، وعدّة مسائل أُخرى، فإنّ وفقني الله تعالى، فإنّ هذا القسم الثاني سيجمع ويدوّن بعد ذلك ويُطبع بصورة جزء ثانٍ ويهيّأ للنشر.
نسأل الباري تعالى التوفيق والهداية.
قلهك - 28 شهريور / 53 شمسي
المصادف للثاني من شهر رمضان المبارك / 1394 قمري
مرتضى المطهّري
نظام حقوق المرأة
تمهيد
من دواعي سروري أنّ مجلة (زن روز) أي (المرأة اليوم) أعلنت موافقتها على طلبي، فيما يخص البحث في الاقتراحات الأربعين للمجلة، من أجل تغيير مواد القانون المدني الإيراني في المسائل التي تتعلّق بأمور الأُسرة، وأنّها أعلنت في العدد السابق موافقتها على نشر هذه السلسلة من المقالات مع نشر رسالتي بهذا الخصوص.
إنّني أغتنم هذه الفرصة لأضع بين يدي الشبّان جانباً من الفلسفة الاجتماعية في الإسلام، آملاً أن يكونوا على بصيرة وتفتّح ذهنٍ فيما يختص بالمسائل المتعلّقة بالروابط العائلية في نظر الإسلام.
لقد ذكرت في رسالتي أنّني لا أريد أن أدافع عن القانون المدني وأقرّه على أنّه كامل مانع ومطابق مئة بالمئة للقوانين الإسلامية والموازين الاجتماعية الصحيحة؛ إذ قد تكون لديّ اعتراضات عليه، كما لا أريد أن أقرّ بصحّة التقاليد المنتشرة بين أكثرية الناس ومطابقتها للعدالة، فأنا أشاهد بوضوح اضطراب العلاقات العائلية وأعتقد بضرورة إجراء إصلاحات أساسية في هذا الباب.
لكنّني بخلاف بعض الكتّاب من أمثال مؤلّف كتاب (انتقاد بر قوانين أساسى ومدنى إيران) أي (انتقاد القانون الأساسي والقانون المدني
الإيراني) ومؤلّف كتاب (پيمان مقدس إزدواج) أي (الرباط المقدّس، أو عقد الزواج) لا أُبرّئ الرجال الإيرانيين مئة في المئة، ولا أُلقي بكامل التبعات على القانون المدني، ولا أرى ذنب القانون المدني في تبعيته للفقه الإسلامي، ولا أرى الطريق الوحيد للإصلاح، في تغيير مواد القانون المدني. إنّما أقوم في هذه السلسلة من المقالات بتناول تلك المجموعة من المواد القانونية الإسلامية المتعلّقة بحقوق الزوجين وعلاقاتهما مع بعضهما أو مع أطفالهما أو مع الأفراد خارج البيت، والتي أشير إليها وأقترح تغييرها، فابحثها مادة مادة، وأثبت أنّ هذه المواد قد أخذت بنظر الاعتبار بصورة دقيقة الجوانب النفسية والطبيعية والاجتماعية، ونظرت إلى الكرامة والشرف الإنساني للمرأة والرجل على السواء، وهي ضامنة لحسن العلاقات العائلية في حالة العمل بها والدقّة في تنفيذها على أحسن وجه.
وأرجو من القرّاء المحترمين أن يسمحوا لي - قبل الدخول في هذه المسائل - أن أشير إلى بعض النقاط:
1 - المشكلة العالمية للعلاقات الأُسرية (العائلية)
إنّ مشكلة العلاقات الأُسرية في عصرنا الحاضر ليست من السهولة والبساطة بحيث تحل بملء بطاقات (القسائم) من قِبَل الأولاد والبنات، أو عقد الندوات من النوع الذي رأينا وسمعنا واطلعنا على مستواه الفكري، ولم تحلها بلادنا خاصة، ولا حلّها الآخرون ولا ادعوا حلّها
حلاًّ واقعياً. يقول (ويل ديورانت) الفيلسوف وكاتب تاريخ الحضارة المعروف: (لو فرضنا أنّنا الآن في عام ألفين ميلادي وأردنا أن نعرف ما هو أعظم حدث وقع في الربع الأوّل من القرن العشرين. فسنرى أنّ هذا الحدث لم يكن الثورة الروسية، بل هو هذا التغيّر في وضع المرأة، فإنّ التاريخ قلّما شهد تغييراً مثيراً بهذه الدرجة وفي مثل هذه المدّة القصيرة، وقد شمل هذا التغيير البيت المقدّس الذي كان أساس نظامنا الاجتماعي وقاعدة الحياة الزوجية الواقي من اتباع الشهوات وتزلزل وضع الإنسان والقانون الأخلاقي الذي أخرجنا من الوحشية إلى الحضارة، وآداب المعاشرة، كل ذلك طالته هذه النقلة المضطربة التي شملت كل عادات وصور حياتنا وتفكيرنا).
والآن ونحن في الربع الثالث من القرن العشرين، تصل إلى آذاننا أكثر من ذي قبل، آهات المفكّرين الغربيين من تفكّك الأُسرة وضعف أُسس الزواج.... من تخلّي الشبّان عن قبول مسؤولية الزواج.... من النفور الأُمومة.... من تقلّص علاقة الأبوين وعلى الأخص علاقة الأُم بالأطفال... من تبذّل المرأة وحلول الهوى الطارئ محلّ الحب.... من ازدياد الطلاق المستمر.... من الزيادة المقرفة للأطفال غير الشرعيين، ومن ندرة وجود الإخلاص بين الزوجين.
هل نستقل أم نقلّد الغرب؟!
ممّا يؤسف له أنّ مجموعة من الجهلاء يتصوّرون أنّ الأُمور المتعلّقة
بروابط الأُسرة، تشبه الأُمور المتعلّقة بتنظيم المرور، وسيّارات الأُجرة والسيارات العامّة لنقل الركاب، ومد أنابيب الماء والكهرباء والتي كانت قد حلّت عند الأوروبيين منذ سنوات على أحسن ما يُرام، وإنّنا لا نملك الأهلية واللياقة لوضع الحلول، ويجب علينا اتباع أُولئك بأسرع ما يمكن.
هذا وهم محض، فالغربيون في هذه الأُمور أعجز منّا وأكثر تورّطاً، وصيحات عقلائهم أعلى من صيحاتنا، ففيما عدا مسألة تعليم المرأة، نجدهم في باقي المسائل أعجز منّا، وقلّما يتمتّعون بالسعادة في بيوتهم.
الحتميّة التاريخية
والبعض الآخر لهم تصوّر آخر؛ فهم يرون أنّ ضعف نظام الأُسرة وسريان الفساد إليها ناتج عن تحرّر المرأة. وتحرّر المرأة هو نتيجة حتمية للحياة الصناعية والتقدّم العلمي والحضاري وحتمية تاريخية، ولابد أن نستسلم لهذا الفساد والاضطراب، ونغضّ النظر عن تلك السعادة العائلية التي كانت موجودة في الزمان القديم.
إذا كان هذا هو تفكيرنا، فهو سطحي جداً. أؤيّد أنّ العصر الصناعي قد ترك أثره ويتركه على العلاقات العائلية رضينا أم أبينا، ولكنّ العامل الأساس في تمزّق العائلة في أوروبا شيئان آخران.
الأوّل: العادات والتقاليد والقوانين الجائرة والجاهلة التي كانت سائدة بينهم قبل هذا القرن فيما يتعلّق بالمرأة إلى حدّ أنّ المرأة لم
تحصل على حقوقها في الملكية لأوّل مرّة إلاّ في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.
والثاني: إنّ الأشخاص الذين أرادوا إصلاح أوضاع المرأة سلكوا نفس الطريق الذي يسلكه اليوم بعض أدعياء الثقافة العصرية عندنا، وما الاقتراحات الأربعون إلاّ مظهر من مظاهر ذلك الطريق، لقد أرادوا تجميل حاجب المرأة، ففقأوا عينها.
وقبل أن تكون الحياة الصناعية مسؤولة عن هذا الاضطراب، كانت قوانين أوروبا القديمة وإصلاحاتها الجديدة هي المسؤولة الكبرى عن ذلك.
لذا فبالنسبة لنا - شعوب الشرق الإسلامي - لسنا ملزمين بسلوك الطريق التي سلكوا، والسير حيث ساروا، والخوض في أيّ مستنقعٍ خاضوا، إنّما يجب علينا أن ننظر إلى الحياة الغربية بيقظةٍ وحذر. فمن خلال الإفادة والاقتباس من العلوم والصناعات والتكنيك وقسم من النظم الاجتماعية القابلة للتعديل، نتجنّب تقليد العادات والقوانين التي جلبت لهم آلاف التعاسات والمصائب، مثل: تغيير قوانين إيران المدنية والعلاقات العائلية وجعلها مطابقة للقوانين الأوروبية.
2 - نحن والقانون المدني
بغضّ النظر عن كون هذه الاقتراحات هدماً للبيت والأُسرة ومخالفة للمتطلبات الروحية والطبيعية والاجتماعية، كما سنوضح ذلك
فيما بعد، ولكن هل عرضت على القانون الأساسي؟ فمن جهة، يصرّح القانون الأساسي أنّ كل قانون يخالف قوانين الإسلام غير قانوني وغير قابل للعرض على المجلسين. ومن جهةٍ أُخرى، فإنّ أغلب مواد هذه المقترحات مخالفة لقانون الإسلام مخالفة صريحة. فهل إنّ الغربيين الذين يقلدهم مثقفونا العصريون على هذا النحو الأعمى، يرضون لقانونهم الأساسي أن يصبح ألعوبة بهذا الشكل؟
وبغضّ النظر عن الدين، فإنّ القانون الأساسي لكل بلد مقدّس عند أفراد ذلك البلد، وهو بالنسبة إلى إيران كذلك محل احترام الشعب الإيراني بأجمعه. فهل يمكن أن يوضع القانون الأساسي تحت الأقدام عن طريق الندوات وطبع القسائم ونشاط النواب؟
3 - العواطف الدينية للمجتمع الإيراني
بغضّ النظر في الوقت الحاضر عن عيوب هذه المقترحات ومخالفتها الصريحة للقانون الأساسي، ومهما ننكر فلا يمكن أن ننكر أنّ أقوى عاطفة تحكم مشاعر الشعب الإيراني هي العاطفة الإسلامية. دعونا الآن عن القلّة التي تخلّت عن كل قيدٍ وشرط وصارت تجري وراء كل هرج ومرج وتحلل من الالتزام، فإنّ الأكثرية الساحقة لهذا الشعب ملتزمة بالمقرّرات الدينية.
وبخلاف ما كان يتوقّعه البعض، فإنّ الدراسة وطلب العلم لم يكونا السبب في الفصل بين الأُمّة ودينها، بل العكس هو الصحيح، فبالرغم من
أنّ التوجيه الديني الصحيح قليل، والحرب الفكرية الدعائية للاستعمار شديدة ضدّ الدين، إلاّ أنّنا نجد المتعلّمين والمثقفين يتجهون نحو الإسلام بشكل مطّرد. والآن أتساءل كيف ستنسجم هذه القوانين مع وجود هذه المشاعر الموجودة شئنا أم أبينا؟ وكيف سنتصرّف حين لا يتفق قانون العرف مع الحكم الشرعي الصريح؟ لنفرض أنّ امرأة - على أثر الخلاف والغضب - رجعت إلى المحكمة واستصدرت حكم طلاقها من زوجها على الرغم منه، ثم تزوّجت من رجلٍ ثانٍ. هذه المرأة وزوجها الجديد في الوقت الذي يعتبران نفسيهما بحكم القانون العرفي زوجاً وزوجة؛ يدركان في عمق وجدانهما الديني أنّهما أجنبيان عن بعضهما وأنّ اتصالهما غير مشروع، وأطفالهما أولاد زنا وأنّهما من وجهة نظر الدين يستحقان الإعدام.
في هذه الحالة، ماذا ستكون حالتهما النفسية؟ وبأيّ عين سينظر الأصدقاء والأقارب المتديّنون إليهما والى أولادهما؟ إنّنا في الواقع لا يمكن أن نغيّر الوجدان الديني للشعب بتغيير أو وضع قانون ما، وللأسف أو لحسن الحظ أنّ وجدان أكثر الأقرباء باتفاق الناس ليس خلواً من العاطفة الدينية.
فلو أنّكم جئتم من الخارج بمتخصّص حقوقي ونفساني وطلبتم رأيه وقلتم: إنّنا نريد أن نضع مثل هذا النوع من القوانين ولكنّ الأساس النفسي لأكثرية الشعب هو كذا وكذا، وانظروا هل سيوافقونكم؟ أم
سيقولون إنّ ذلك سيؤدّي إلى آلاف المشاكل الروحية والاجتماعية؟
والمقارنة بين هذا النوع من القوانين والقوانين الجزائية من ناحية الآثار السيّئة التي تتركها، خطأ محض. فالفرق بين القانونين كالفرق بين السماء والأرض، وإنّ تغيير أو تعطيل القوانين الجزائية يلحق الأذى والضرر بالمجتمع كلّه، ويزيد المنحرفين جرأةً وحرصاً على تحدّي القوانين. أمّا القوانين المتعلّقة بروابط الزوجين والأطفال فإنّها ترتبط بحياة الأفراد الشخصية والخاصة، وتدخل في معركة مباشرة في مقابل العاطفة الدينية للشخص. ومثل هذه القوانين تبقى معطّلة في حالة تمكّن الدين وغلبة الوجدان وتؤدّي المشاكل التي تنتج عنها إمّا إلى إلغائها في النهاية رسميّاً - رضينا أم أبينا - أو إلى إضعاف الوازع الديني نتيجة حدوث الصراعات الدينية داخل نفس الإنسان.
الفصل الأوّل
طلب اليد والخطبة
أبدأ حديثي حول المواد الأربعين المقترحة من هذه النقطة؛ لأنّ المقترحات بدأت من هنا، باعتبار أنّ هذا هو الموضوع بالترتيب الذي تناوله (القانون المدني).
ونظراً لأنّ المواد التي تتناول الخطبة وطلب اليد في القانون المدني ليست قوانين إسلامية بصورة مباشرة، أي أنّ أغلبها لم يستمد بصورة مباشرة من نص إسلامي واضح، كما أنّ القانون المدني في هذا المجال لم يستنبط أُصوله من القواعد الإسلامية العامة - كما يُدّعى - لذا لا أراني ملزماً بالدفاع عنه أو الدخول في بحث تفاصيل النظريات المقترحة. ومع أنّ المقترح قد ارتكب أخطاء كبيرة في هذا الباب، وعجز حتى عن أدراك المفاهيم الصحيحة لهذه المواد البسيطة، إلاّ أنّه لا يمكن أن نغضّ النظر عن أمرين هنا:
1 - هل يُعدّ طلب الرجل يد المرأة إهانةً لها؟
يقول مقترح المواد: (إنّ قانوننا المقرتح حتى في هذه المواد (المتعلقة بالخطبة وطلب اليد) لم ينس هذا المبدأ الرجعي والإنساني القائل بأنّ الرجل أصل والمرأة فرع، فنجد أنّ المادة 1034، وهي المادة الأُولى في باب النكاح والطلاق، قد صيغت على النحو التالي:
(مادة 1034: - يمكن أن تطلب يد كل امرأة فارغة من موانع النكاح). وكما تلاحظون فإنّ المرأة بموجب هذه المادة - وإن لم يكن هناك إلزام - يطرح زواجها من الرجل بعنوان (أخذ امرأة) وهو يتلقّى ذلك بوصفه مشترياً يتعامل مع بضاعة. إنّ أمثال هذه التعبيرات في القوانين الاجتماعية تترك أثراً نفسيّاً سيّئاً جداً، وخاصةً التعبيرات المذكورة في قانون الزواج فإنّها تترك أثراً على علاقة الرجل بالمرأة؛ إذ تمنح الرجل موقع السيد والمالك والمرأة موقع المملوك والعبد).
وعلى أثر هذه الملاحظة النفسية الدقيقة، ولكي تؤخذ المواد التي ذكرها المقترح حول (طلب اليد) من طرف واحد بعنوان (أخذ امرأة) فقد اعتبر طلب اليد جزءاً من عمل المرأة كما هو جزء من عمل الرجل؛ لكي لا يصدق على الزواج (اخذ المرأة) فقط، وإنّما يصدق أيضاً على (أخذ رجل) أو على الأقل لا هذا ولا ذلك. فإذا قلنا أخذ امرأة، أو كلّفنا الرجال أن يقوموا هم دائماً بطلب أيدي النساء، فإنّنا نهبط بذلك بمكانة المرأة، ونجعل منها بضاعة معروضة للشراء.
غريزة الرجل الطلب والحاجة وغريزة المرأة التمنّع والدلال
من غريب الصدف أن يكون هذا الأمر موضع خطأ فاحش. فهذا الخطأ هو نفسه الذي جرّ إلى اقتراح إلغاء المهر والنفقة، وهذا ما سنفصله في بحث المهر والنفقة.
ان الذي كان يجري منذ قديم الزمان - وهو ان يذهب الرجال
طالبين أيدي النساء ومظهرين الرغبة في الزواج منهن - هو من أكبر عوامل حفظ مكانة المرأة واحترامها فالطبيعة قد جعلت الرجل ممثّلاً للطالب والمحب، والمرأة ممثّلة للمطلوب والمحبوب. إنّها جعلت المرأة وردةً والرجل بلبلاً.. المرأة شمعة والرجل فراشة، وأنّه لمن حكمة التدبير وآيات الخلقة أن جعلت في غريزة الرجل الحاجة والطلب وفي غريزة المرأة الدلال والتمنّع. فهي بذلك تداري ضعفها مقابل قوّة الرجل.
ليس من كرامة المرأة واحترامها أن تجري خلف الرجل؛ إذ إنّ الرجل يطيق أن يخطب المرأة وتردّه وعندها يخطب أُخرى وتردّه حتى يفوز أخيراً برضا إحدى النساء للاقتران به. أمّا بالنسبة للمرأة حيث تريد أن تكون محبوبة الرجل ومعشوقة ومحلّ عنايته، وتنوي الاستيلاء على قلبه كي تحكم كل وجوده، فأكبر من طاقتها وخلاف غريزتها أن تدعو رجلاً للزواج منها فيردّها ثم تذهب لخطبة آخر.
وفي نظر (وليام جيمس) الفيلسوف الأمريكي المعروف: إنّ حياء وتمنّع المرأة الظريف ليس غريزة، فإنّ بنات حوّاء على مرّ التاريخ أدركن أنّ عزّتهن واحترامهن في أن لا يجرين وراء الرجل، ولا يظهرن الابتذال ولا يكنّ قريبات من متناول الرجل، إنّ النساء أدركن هذه الدروس طول التاريخ وعلمنها لبناتهن.
وهذا لا يختص بالنوع الإنساني فحسب، فباقي الحيوانات أيضاً
كذلك فإنّه قد عهد لجنس الذكور أن يقوموا بعرض حبّهم وحاجتهم لجنس الإناث. أمّا ما عهد به إلى جنس الإناث فهو أن يعتنين بجمالهن ورقتهن ويصطدن قلب الجنس الخشن بالتمنّع الظريف وإظهار استغنائهن عنه، فيسخّرنه لخدمتهن بالطريقة التي تستهوي قلبه وتتهيج بها مشاعره وأحاسيسه فينجرف نحوهن بإرادته ومحض اختياره.
الرجل يشتري العلاقة الودّيّة للمرأة لا رقبتها
عجباً! يقولون لماذا تشم من تعبيرات القانون المدني رائحة شراء الرجل للمرأة؟
أوّلاً: إنّ هذا لا يرتبط بالقانون المدني بل يرتبط بالخلقة، ثانياً: هل إنّ كل شراء هو من نوع الملك والتملّك؟ فالطالب والدارس مشترٍ للعلم، والمتعلّم مشترٍ للعالم، وعاشق الفن مشترٍ للفنّان. فهل نسمّي ذلك تملّكاً ونعدّه منافياً لكرامة العلم والعالم والفن والفنّان؟ إنّ الرجل مشترٍ لمودّة المرأة لا لرقبتها.
فهل تجد في الواقع إهانة لجنس المرأة في شعر شاعرنا ذي الكلام العذب حافظ: إذ يقول ما ترجمته:
شيراز أصل شفاه العقيق ومعدن الحسن
وأنا جوهري مفلس ولذا أعيش في قلق
مدينة مليئة بالجمال والحسان من ست جهات
وأنا لا أملك شيئاً وإلاّ لاشتريت الستّ كلّها(1)
إنّ حافظا يأسف لأنّه لا يملك شيئاً يدفعه للطيبات ويجلب به انتباههن واهتمامهن إليه. فهل هذه إهانة لمقام المرأة، أم مثال لأعلى مظاهر الاحترام لمقامهنّ لدى القلوب الحيّة والحسّاسة التي تخضع وتخشع بكل رجولتها أمام جمال وظرف المرأة، وتعلن حاجتها لحبّها واستغناء المحبوبة عنها؟
إنّ أقصى فنّ المرأة أنّها استطاعت أن تجذب الرجل إلى ساحتها في أيّ مقامٍ وموضعٍ كان.
والآن انظروا كيف يلوثون - باسم الدفاع عن حقوق المرأة - أكبر خصّيصة وشرف ومكانة للمرأة.
وهذا ما ذكرناه من أنّ هؤلاء السادة يريدون أن يصلحوا حاجب المرأة المسكينة فإذا بهم يفقأون عينها.
____________________
(1) الأصل الفارسي للأبيات المذكورة هو:
شيراز معدن لب لعل است وكان حسن |
من جوهرى مفلس از أرو مشوشم |
|
شهريست پر كرشمه وخوبان زشش جهت |
چيزي نيست ورنه (خريدار) هر ششم |
طلب اليد تدبير ظريف من أجل حفظ مكانة المرأة
قلنا إنّ الرجل في قانون الخلقة، خُلق مثالاً للحاجة والطلب والمبادرة، والمرأة مثالاً للمطلوبية والإجابة، وهذا أحسن ضمان لكرامة المرأة واحترامها وتفادٍ لضعفها مقابل قوّة الرجل، وهو كذلك أحسن عامل لحفظ التوازن في حياتهما المشتركة، وهذا يمثّل نوعاً من الامتياز الطبيعي الذي مُنحت إيّاه المرأة ونوعاً من الواجب الطبيعي الملقى على عاتق الرجل.
والقوانين التي يضعها البشر، أو التدابير القانونية المعمول، بها يجب أن تحفظ للمرأة هذه الميزة وللرجل هذا الواجب، والقوانين المبنية على مساواة الرجل بالمرأة في واجبات وآداب الخطبة إنّما تسيء إلى مصالح وكرامة المرأة واحترامها، كما أنّها تقضي على التعادل بين الاثنين؛ في الظاهر لمصلحة الرجل وفي الواقع ضد مصلحة الطرفين.
وعلى هذا، فالمواد المقترحة من قِبَل كاتب الأربعين اقتراحاً، والمبنية على أساس اشتراك المرأة في واجب الخطبة، ليست لها أي قيمة، كما أنّها تسيء إلى المجتمع الإنساني ككل.
2 - وقوع كاتب الأربعين اقتراحاً حول القانون المدني في الخطأ:
الأمر الثاني الذي أريد الإشارة إليه في هذا الفصل أنّ السيد المهدوي كاتب الأربعين اقتراحاً، كتب في العدد 86 من مجلة (زن
روز) أي (امرأة اليوم) صفحة 72: (بموجب المادة 1047 إذا أراد أحد الخطيبين أن يفسخ الخطبة بدون سببٍ وجيه، يجب عليه أن يعيد إلى الطرف المقابل الهدايا التي أهداها والده أو أشخاص آخرون لهم صلة بالأول، وإذا لم تكن عين هذه الهدايا موجودة، يجب أن يعيد قيمتها، إلا إذا كانت قد تلفت بدون تقصير.
فطبقاً لضوابط هذه المادة، تعتبر الخطبة - بنظر المشرّع - كالوعد بالزواج لا تملك أيّ أثرٍ قانوني، ولا تملك أيّ ضمانة إجرائية أيضاً ولا تتطلّب من الطرفين التزاماً معيّناً، إنّما الأثر الذي يترتّب عليها هو أنّ الطرف المخالف - كما يعبّر عنه كاتب القانون المذكور (بدون سبب وجيه) - إذا قطع الصلة، يجب عليه أن يعيد الهدايا التي كان تسلّمها من الطرف الآخر، ولكن الطرفين في مرحلة الخطوبة - غالباً - لا يتهاديان شيئاً تحت عنوان الخطوبة، إنّما يتحمّلان نفقات باهضة تقتضيها الخطوبة نفسها...).
وكما تلاحظون فإنّ اعتراض السيد المهدوي على هذه المادّة هو: أن لا أثر قانونياً ولا ضمانة إجرائية للخطوبة، وإنّما الأثر الوحيد لها هو كون الطرف الناقض للخطبة ملزماً بردّ عين الهدايا التي كان قد تسلّمها أو قيّمها، بينما الخسارات الرئيسية التي يتحمّلها الشخص إبان الخطوبة هي خسارات من نوع آخر مثل مصروفات إقامة حفل، أو دعوة ضيوف أو فسحات الخطيبين.
وأنا أقول إنّ هناك اعتراضاً آخر أيضاً يرد على هذه المادة في القانون؛ وذلك قولها: إنّ الطرف الناقض للخطبة (بدون سبب وجيه) يجب أن يعيد الهدايا التي تسلّمها، بينما المتعارف أنّ الصلة لو قطعت بدون سبب وجيه أيضاً، تعاد عين الهدايا التي أُعطيت على الأقل إذا طالب بها الطرف المقابل.
لكن الحقيقة أنّ أيّاً من الاعتراضين ليس سليماً.
يورد القانون المدني في المادة 1036 ما يلي: (إذا قطع أحد الخطيبين هذه الصلة بدون سبب وجيه في الوقت الذي كان الطرف المقابل أو الأبوان أو أشخاص آخرون قد أنفقوا أموالاً وغرّر بهم على أمل حصول الزواج، فعلى الطرف الفاسخ أن يعوّض الخسارة. لكنّ الخسارة المذكورة تتعلّق فقط بالمصروفات المتعارفة).
هذه المادة تبيّن نفس الأمر الذي تصوّر السيد المهدوي أنّ القانون لم يتداركه، وهي المادة التي ذكرت فيها عبارة (بدون سبب وجيه) وطبقاً لهذه المادة لا يتحمّل الطرف الفاسخ ما أنفقه الخطيب الآخر فحسب، بل ما أنفقه أبواه وغيرهما من الأشخاص كذلك.
وفي هذه المادة، بالاستناد إلى كلمة (غرّر بهم) يكون القانون قد أشار إلى القاعدة المعروفة بقاعدة (التغرير).
هذه بالإضافة إلى أنّ التسبيب في القانون المدني يُعدّ أحد موجبات الضمان الإجباري، ويمكن إحراز ذلك أيضاً من المادة (332)
المتعلّقة بالتسبيب حيث يُفهم منها ضمان الطرف المخالف.
وعلى هذا فإنّ القانون المدني لم يسكت على خسارات الخطوبة (التي وصفها كاتب المقترحات بالخسارات التي تحصل خلال الخطوبة نفسها) وحسب، وإنّما ضمنها من خلال مادّتين.
فالمادة 1037 تقول: (يحق لكلٍّ من الخطيبين - في حالة فسخ الخطوبة - أن يطالب باستعادة الهدايا التي أعطاها لخطيبه أو أعطاها أبواه أو الآخرون من أجل الخطيب الأوّل، وإذا كانت الهدايا مفقودة، فقيمة الهدايا التي لها قيمة معتبرة إلاّ إذا كانت تلك الهدايا قد تلفت بدون تقصير الطرف المقابل).
هذه المادة تتعلّق بالأشياء التي أهداها كل من الخطيبين للآخر. وكما تلاحظون فإنّ هذه المادة لم تشر إلى قيدٍ أو شرطٍ باسم (بدون سبب وجيه)، إنّما هذا الشرط الأخير قد استنبطه السيد المهدوي نفسه.
وأعجب لأشخاص عاجزين عن فهم عدّة مواد بسيطة في القانون المدني (مع أنّهم قد قضوا أعمارهم في دراستها، وخُصّصت لهم ميزانية خاصة من أموال هذا البلد باسم التخصّص الفنّي في هذه القوانين نفسها) كيف يدعون إلى تغيير قوانين سماوية ضمّت آلاف الملاحظات والتفصيلات؟
وهناك نقطة لابد من ذكرها، وهي أنّ السيد المهدوي إلى ما قبل خمس سنوات - حين كان مشغولاً بتأليف كتابه (پيمان مقدس يا ميثاق ازدواج) أي (الميثاق المقدّس أو ميثاق الزواج) - كان يقرأ
الجملة المذكورة على هذه الصورة (بدون سبب وموجب). وفي كتابه عقد فصلاً طويلاً، وصال وجال قائلاً: (وهل في الدنيا عمل بدون سبب وموجب). لكنّه أخيراً تنبّه إلى أنّه كان لسنوات يقرأ هذه الجملة مغلوطة ففهمها وصار يقرأها (بدون سبب وجيه).
والى هنا أغضّ النظر عن باقي الاعتراضات التي يمكن إيرادها على كاتب المقترحات.
الفصل الثاني
(1) الزواج المؤقّت
إنّني - على العكس من الكثيرين - لا أغضب من الشكوك والشبهات التي تُثار حول الإسلام، بالرغم من حبّي لهذا الين واعتقادي به، بل أفرح من أعماق قلبي؛ لأنّني أعتقد - وقد علّمتني التجربة - أنّ الهجوم على هذا الدين السماوي المقدّس كلّما كان أقسى وأشدّ - في أي جبهة من الجبهات - ازداد جلاءً وبهاءً وبدا مرفوع الهام قويّاً.
فخاصيّة الحقيقة هي أنّ الشك والتشكيك يزيدانه نوراً، فالشك يؤدّي إلى اليقين، والتردّد يؤدّي إلى التحقيق. ورد في رسالة (زنده بيدار) أي (الحي القيّوم) نقلاً عن رسالة (ميزان العمل) للغزالي، قوله: (لو كانت لكلامنا فائدة واحدة فقط وهي أن تجعلك تشك في عقائدك القديمة الموروثة لكان ذلك كافيا. ذلك أنّ الشك أساس التحقيق، والشخص الذي لا يشك يفوته التأمّل والتدقيق. ومَن لا ينظر جيداً لا يرى جيداً، ومثل هذا الشخص يبقى في العمى والحيرة).
فدعهم يقولوا ويكتبوا ويعقدوا الندوات ويثيروا الشبهات، من أجل أن تظهر حقائق الإسلام جليّة على الرغم منهم.
* * *
من قوانين الإسلام النيّرة في نظر المذهب الجعفري، الذي هو المذهب الرسمي لبلادنا، أنّ الزواج يتم بنحوين: دائم ومؤقت.
الزواج المؤقّت والدائم يتفقان في بعض الأُمور ويختلفان في البعض الآخر. والذي يميّزهما عن بعضهما بالدرجة الأُولى أنّ المرأة والرجل في الزواج المؤقّت يتفقان على أن يكونا زوجين لمدّة معيّنة فقط، وبعد انتهاء المدّة إن رغبا في تمديدها مدّداها، وإلاّ افترقا.
والفرق الثاني هو امتلاكها حرية أكثر في إدخال الشروط التي يرغبان فيها في العقد. فمثلاً إذا كان الزوج في الزواج الدائم ملزماً بأداء نفقات البيت واللباس والمسكن وباقي احتياجات الزوجة من دواء وطبيب وغيره، فإنّه في الزواج المؤقّت يتبع اشتراط ذلك رغبة الزوجين، إذ من المحتمل أنّ الرجل لا يريد أو لا يقدر على أداء نفقات المنزل أو غيره أو أنّ المرأة لا تنوي الإفادة من مال الرجل.
في الزواج الدائم، لابد للزوجة أن تتعامل مع الزوج على أنّه رئيس العائلة وتطيع أمره في حدود مصلحة العائلة، أمّا في الزواج المؤقّت فالأمر راجع إلى الاتفاق بينهما.
في الزواج الدائم - رضيا أم أبيا - يرث كل من الزوجين صاحبه، أمّا في المؤقّت فلا إرث بينهما.
إذاً، الفرق الأساس والجوهري بين الزواج المؤقّت والدائم هو أنّ الزواج المؤقّت (حر) من حيث حدوده وقيوده، أي بإرادة واتفاق
الطرفين. وحتى توقيته يمنح الطرفين - في الحقيقة - حرية، إذ يحدّدان هما مدّة مفعوله.
في الزواج الدائم، لا يحق لأي من الزوجين أن يمنع الحمل بدون موافقة الطرف الآخر، أمّا في المؤقّت فلا يشترط موافقة الطرف الآخر من أجل منع الحمل. وهذا نوع آخر من الحرية أُعطي للزوجين.
الأطفال الذين يولدون من الزواج المؤقّت لا يختلفون في شيء من الحقوق عن الأطفال المتولّدين من الزواج الدائم.
المهر واجب في الزواج الدائم وفي الزواج المؤقّت كذلك، مع فرقٍ واحدٍ هو أنّ عدم ذكر المهر يبطل العقد المؤقّت ولا يبطله في العقد الدائم، بل يكون للمرأة مهر المثل.
وكما تحرم في العقد الدائم أُم وأُخت الزوجة على الزوج، ويحرم أبو وابن الزوج على الزوجة، كذلك يحرمون في العقد المنقطع، وكما أنّ خطبة المتزوّجة بالعقد الدائم حرام على الآخرين كذلك طلب يد المتزوجة بالعقد المؤقّت حرام على الآخرين. وكما أنّ الزنا بالمحصنة ذات العقد الدائم يوجب الحرمة الدائمة على الزاني، كذلك الزنا بالمحصنة ذات العقد المنقطع يوجب الحرمة الدائمة على الزاني. وكما يجب على الزوجة الدائمة أن تعتد بعد الطلاق، فكذلك يجب على الزوجة المؤقّته أن تعتد بعد الطلاق، فكذلك يجب على الزوجة المؤقتة أن تعتد بعد إتمام المدّة أو هبتها، مع فارق أنّ عدّة الزوجة الدائمة ثلاث
حيضات، وعدّة الزوجة غير الدائمة حيضتان أو خمسة وأربعون يوماً. وكما لا يجوز الجمع بين الأُختين في الزواج الدائم، كذلك لا يجوز الجمع بينهما في الزواج المؤقّت، هذا هو عين ما ورد في فقه الشيعة باسم الزواج المؤقّت، أو النكاح المنقطع، وكذلك في القانون المدني.
وبديهي، أنّنا نؤيّد هذا القانون بهذه التفصيلات، أمّا كون أبناء شعبنا قد أساءوا استخدام هذا القانون، وما زالوا، فهذا ممّا لا علاقة له بنفس القانون. وإلغاء هذا القانون لا يحول دون إساءة التصرّف إنّما يغيّر شكل الإساءة، بالإضافة إلى أنّ مئات المفاسد ستعقب إلغاء القانون.
إننا يجب ألاّ نهاجم القانون عندما نعجز عن إصلاح الناس وتوعيتهم، فنبرّئ الناس ونتّهم القانون.
والآن لنر ما هي الضرورة لوجود قانون باسم قانون الزواج المؤقّت مع وجود الزواج الدائم، وهل أنّ الزواج المؤقّت - كما تقول مجلة (زن روز) أي (امرأة اليوم) - يتنافى مع مكانة الإنسانية للمرأة ومع روح لائحة حقوق الإنسان؟ وهل حقّاً أنّ الزواج المؤقّت حتى ولو كان ضرورياً فإنّما ضرورته في السابق؟ وهل أنّ حياة اليوم وظروف العصر ومقتضياته ممّا يتنافى وإيّاه؟
سأبحث هذا المطلب تحت عنوانين:
ألف - الحياة العصرية والزواج المؤقّت.
باء - المآخذ على الزواج المؤقّت.
الحياة العصرية والزواج المؤقّت
كما عرفنا من البدء، فإنّ الزواج الدائم يحمّل الزوجين مسؤولية وتكاليف كثيرة؛ لذا لا يمكن للفتى أو الفتاة بمجرّد البلوغ - حيث ضغط الغريزة على أشدّه - أن يتزوّجا بالعقد الدائم. إنّ ميزة العصر الحديث هي أنّه أطال المدّة الفاصلة بين البلوغ الطبيعي والبلوغ الاجتماعي حيث يمكن للشاب أن يكوّن عائلة. ففي العصور السابقة، لو أنّ عملاً أوكل إلى فتى في أوّل بلوغه لتمكّن أن يستمر فيه حتى آخر عمره، أمّا اليوم فهذا الأمر غير مقبول؛ لأنّ الفتى الذي يوفّق في إكمال الدراسة الابتدائية والثانوية والجامعة بدون تأخّر ولا رسوب في الامحانات السنوية النهائية، ولا الامتحان العام للجامعة، يتخرّج آنذاك وعمره عشرون سنة ويستطيع بعد ذلك فقط أن يكون دخلاً خاصاً به. ممّا سيضطرّ إلى الصبر ثلاث أو أربع سنوات ريثما تكون لديه كمّيّة من المال يتهيأ بها للزواج الدائم، كذلك الأمر بالنسبة إلى أيّ فتاة موفّقة طوت سني الدراسة بنجاح.
شباب اليوم ومرحلة البلوغ والتهيّج الجنسي
لو كنت في هذا اليوم شابّاً ذا ثمانية عشر عاماً، حيث بلغ عندك الهياج الجنسي أشدّه، وذكرت رغبتك في الزواج، لضحكوا منك، كذلك الفتاة ذات الستة عشر عاماً. فعملياً، لا يمكن لأهل هذا السن أن يرتبطوا برباط الزواج الدائم أو يتحمّلوا مسؤولية حياة ذات واجبات وتكاليف
كثيرة تجاه بعضهم البعض وتجاه أطفالهم القادمين.
الرهبانية المؤقّتة، أم الشيوعية الجنسية أم الزواج المؤقّت؟
أسألك الآن، ماذا يجب أن نعمل تجاه الطبيعة والغريزة في هذه الحالة؟ هل الطبيعة مستعدّة أن تريحنا من ضغط الغريزة الجنسية بتأخير سن البلوغ لدينا حتى نتخرّج من الجامعة؛ لأنّ العصر لا يسمح لنا بالزواج في سن الثامنة عشرة أو السادسة عشرة؟
وهل الشبّان على استعداد لطيّ مرحلة (رهبانية مؤقّتة) يروضون خلالها أنفسهم على التحمّل إلى أن تتهيّأ لهم إمكانية الزواج الدائم؟ ولو فرضنا جدلاً أنّ شابّاً يرضى أن يفرض على نفسه رهبانية مؤقّتة، فهل ترضى الطبيعة أن تعفيه من الوقوع تحت تأثير العوامل النفسية السيّئة والخطرة الناتجة عن الامتناع عن ممارسة مقتضيات الغريزة الجنسية، والتي كشفت عنها الدراسات العصرية؟
لم يبق إلاّ طريقان، فإمّا أن نترك الشبّان لحالهم بدون توجيه؛ فنجيز للفتى أن يتصل بمئات الفتيات، ونجيز للفتاة أن تعاشر عشرات الشبّان بصورة غير شرعية وتسقط جنينها كلّما شاءت، أي أنّنا نطبّق الشيوعية الجنسية. وبما أنّنا أجزنا للفتى والفتاة (على السواء) أن يفعلا ذلك، فقد أرضينا روح لائحة حقوق الإنسان؛ لأنّ هذه الروح - بنظر كثير من قاصري الأفهام - تقتضي بأنّ المرأة والرجل حتى لو أُريد لهما أن يسقطا في جهنّم فلابد أن يكونا جنباً إلى جنب ويداً بيد كي يكون
سقوطهما بالنتيجة (متساوياً).
فهل تصلح مثل هؤلاء الفتيات لتشكيل أُسرة صالحة إثر الزواج بالعقد الدائم بعد كل تلك العلاقات الواسعة خلال مرحلة الدراسة؟
الطريق الثاني الزواج المؤقّت الحر. هذا الزواج يحدّد علاقات المرأة بالدرجة الأُولى؛ إذ لا يمكن أن تكون الفتاة زوجة لاثنين، وبديهي أنّ تقييد المرأة يستوجب تقييد الرجل رضي أم أبى، فحين تختص كل امرأة برجل معيّن يصبح في النتيجة كل رجل مختصاً بامرأة معيّنة، إلاّ إذا كان أحد الطرفين أكثر من الآخر، وبهذه الطريقة ينهي الفتى والفتاة مرحلة الدراسة دون أن يتحمّلا مصاعب الرهبانية المؤقّتة أو يسقطا فريسة الشيوعية الجنسية.
الزواج الاختياري
هذه الضرورة لا تختص بأيام الدراسة فحسب، بل ترد كذلك في ظروف أخرى؛ إذ لا يمكن للمرأة والرجل اللذين يرغبان في الزواج الدائم من بعضهما ولم يحرزا الكامل ببعضهما أن يعقدا زواجاً اختياريا لمدّة معيّنة، فإذا اطمأنا لبعضهما استمرّا وإلا افترقا.
أنا أسأل الآن: ما هي الضرورة التي حدت بالأوربيين إلى وضع عدد من النساء الساقطات في مكان معيّن من كل مدينة تحت إشراف الدولة؟ أليس هو كون وجود العزّاب غير القادرين على الزواج الدائم يشكّل خطراً كبيراً على العوائل والبيوت؟
رسل ونظرية الزواج المؤقّت
يقول برتراند رسل الفيلسوف الانگليزي المعروف في كتاب (الزواج والأخلاق): (... في الواقع أنّنا لو تأمّلنا قليلاً، لوجدنا أنّ الفواحش من النساء، يحفظن لنا عصمة بيوتنا وطهارة نسائنا وبناتنا. وعندما جاهر (لكي) برأيه هذا في عصر (فيكتوريا)، غضب الأخلاقيون غضباً شديداً، دون أن يفهموا أساس هذا الرأي. لكنّهم لم يتمكّنوا أبداً من إثبات خطئه. وكان لسان حال الأخلاقيين أُولئك وكل منطقهم أن: (لو أنّ الناس اتبعوا تعاليمنا، لما وُجدت الفحشاء) لكنّهم يعلمون جيداً أنّ أحداً لا يهتم لتعاليمهم).
كانت هذه هي الأطروحة الغربية للتخلّص من خطر الرجال والنساء العاجزين عن الزواج الدائم، وهي نفسها التي شرّعها الإسلام من قبل. وإذا ما طُبّقت هذه الأطروحة الإفرنجية وقامت مجموعة من النساء التعيسات بهذا الواجب الاجتماعي! فهل ستحقّق المرأة بذلك كرامتها الإنسانية وتحرز مقامها اللائق بها، وتسعد روح لائحة حقوق الإنسان؟
إن برتراند رسل قد خصّص في كتابه فصلاً بعنوان الزواج التجربي قال فيه: (إنّ القاضي ليندسي الذي كان لسنوات طويلة رئيساً لمحكمة دنفر واطلع من خلال منصبه على حقائق كثيرة، يقترح أطروحة باسم (زواج الصداقة) لكنّه للأسف خسر بذلك منصبه الرسمي في أمريكا؛ إذ
ظهر أنّه يفكّر في سعادة الشبّان والشابات أكثر من تفكيره بإيجاد الشعور بالخطيئة لديهم، وقد كان لمساعي الكاثوليكيين وأعداء الزنوج اليد الطولى في عزله.
إنّ أطروحة زواج الصداقة التي اقترحها رجل محافظ وحكيم، قصد منها إيجاد نوع من الثبات في العلاقات الجنسية. فقد انتبه ليندسي إلى أنّ المشكلة الأساسية في الزواج هي افتقاد المال. وضرورة المال ليس من أجل الأطفال المتوقّعين فحسب، بل إنّ تكفّل المرأة بتأمين المعيشة أمرٌ غير لائق؛ لذا يتوصّل إلى وجوب مبادرة الشبّان لتطبيق مبدأ زواج الصداقة الذي يختلف عن الزواج العادي من ثلاث جهات:
الأُولى: ليس القصد من الزواج إنجاب الأطفال.
الثانية: ما دامت الزوجة الشابة لم تنجب أطفالاً ولم تحمل فالطلاق سيكون ميسّراً برضا الطرفين.
الثالثة: في حالة الطلاق، ستكون المرأة مستحقّة لمساعدة تكفل طعامها...
وأنا أشك في فائدة أُطروحة ليندسي. ولو أنّ القانون قبلها لأثرت كثيراً في تحسين الأخلاق).
إنّ هذا الذي يسمّيه (ليندسي ورسل) زواج الصداقة، مع أنّه يختلف قليلاً عن الزواج المؤقّت الإسلامي، إلاّ أنّه ينبئ عن إدراك مفكّرين مثل ليندسي ورسل لمسألة كون الزواج العادي والدائم لا يفي بجميع حاجات المجتمع.
(2) الزواج المؤقّت
إنّ مواصفات الزواج المؤقّت وضرورة وجوده وعدم كفاية الزواج الدائم وحده لسد حاجات الإنسان، خصوصاً في الوقت الحاضر، قد أصبحت محلاّ للبحث، والآن نريد أن ننظر إلى الوجه الثاني للعملة - كما يقول المثل - لنرى ماذا يمكن أن يجر علينا الزواج المؤقّت من أضرار. وأريد أوّلاً أن أنبّه إلى هذه النقطة:
تاريخ كتابة العقائد
ليس هناك موضوع أو أساس معقّد وشائك بين جميع المواضيع والمسائل وأُسس التعبير عن الرأي - بالنسبة للإنسان - أكثر من البحث في تاريخ العلوم والعقائد والسنن والعادات والآداب الإنسانية.
ولذا لم يخض الخائضون في أي موضوع إنساني كما خاضوا في هذه المواضيع، والعجيب أنّه لا يوجد موضوع يستهوي الناس - أكثر من هذا - لإبداء آرائهم فيه.
فعلى سبيل المثال: أنّ أي شخص له إلمام في الفلسفة والعرفان والتصوّف والكلام الإسلامي يقرّ طرفاً ممّا يكتب هذه الأيام - والذي هو غالباً اقتباس من الأجانب أو نفس آرائهم - يدرك ما أقول. ويظهر أنّ المستشرقين وأتباعهم وأذنابهم - من أجل إبداء رأيهم في مثل هذه المسائل - يرون كل شيء ضرورة، إن لم يكونوا يفهمون ويدركون عمق هذه المسائل.
فمثلاً بخصوص المسألة التي تسمّى في العرفان الإسلامي باسم (وحدة الوجود) لم يبق جانب لم يتحدث فيه؟ شيء واحد لم يتحدث فيه وهو أنّ وحدة الوجود ما هي؟ وماذا كان تصوّر أبطالها عنها من أمثال: محي الدين ابن عربي، وصدر المتألّهين الشيرازي؟ وقد تذكّرت مسألة وحدة الوجود حين قرأت بعض الآراء المنشورة في أعداد مجلة (زن روز) أي (امرأة اليوم) حول النكاح المنقطع. فوجدت أنّ كل شيء قد ذكر إلاّ الشيء الذي يشكّل روح هذا القانون وقصد مشرّعه.
وبالطبع فإنّ هذا القانون لكونه (ميراثاً شرقياً) لم ينل الاهتمام اللازم، ولو كان (تحفة غربية) لاختلف الأمر.
قطعاً، لو أنّ هذا القانون جاءنا من الغرب، لعقدت الندوات والمؤتمرات لتنادي أنّ قصر الزواج على العقد الدائم لا ينسجم وظروف النصف الثاني من القرن العشرين، وأنّ جيل اليوم لا يقبل بالزواج الدائم بقيوده هذه، وأنّ جيل اليوم يريد أن يكون حرّاً، وان يحيا حرّاً، ولا يرضى بغير الزواج الحر الذي يختار شخصياً كل حدوده وقيوده...
والآن بما أنّ هذه النغمة قد انطلقت من الغرب، وطرحها أشخاص من أمثال برتراند رسل وليندسي بعنوان (زواج الصداقة)، فإنّها ستسقبل أكثر ممّا يتوقّع من الإسلام نفسه، وسينسى الزواج الدائم ونغدو مضطرّين لأن ندافع عنه وندعو إليه.
اعتراضات
إنّ العيوب التي ذكرت في موضوع النكاح المنقطع هي:
1 - إنّ أساس الزواج يجب أن يكون دائماً، ويتوجّب على الزوجين - منذ أن يعقد زواجهما - أن يوطّنا نفسيهما على أن يكون كل منهما للآخر دائماً، وإلاّ يخطر في مخيّلتهما أن يفترقا، إذاً فالزواج المؤقّت لا يصلح أن يكون عهداً متيناً.
إنّ لزوم كون الزواج دائمياً أمر سليم جداً، لكنّ هذا الاعتراض يردّ حينما نريد أن نحل الزواج المؤقّت محل الزواج الدائم ونلغي الأخير.
لا شك في أنّ الطرفين حين يكونان قادرين على أن يتزوّجا زواجاً دائماً، وقد حصل عندهما الاطمئنان الكامل تجاه بعضهما، وصمّما على أن يرتبط كل منهما بالآخر برباط دائم، فإنّهما يعقدان عقداً دائماً. فالزواج المؤقّت إنّما شُرّع لأنّ الزواج الدائم غير قادر في كل الحالات والظروف أن يفي باحتياجات البشر، والاقتصار على الزواج الدائم يستلزم أن يحيا الأفراد بالرهبانية المؤقّتة أو ينغمسوا في غمرة الشيوعية الجنسية، وإلاّ، فبديهي أنّ أي فتى أو فتاة تتيسّر له أو لها ظروف الزواج الدائم لن يشغل نفسه بأمرٍ مؤقّت.
2 - إنّ الزواج المؤقّت لا يروق لنساء وفتيات إيران على الرغم من كونهن شيعيات المذهب، بل وينظرن إليه على أنّه نوع من الامتهان والاحتقار لهنّ، وهذا يعني أنّ نفس الشيعة قد رفضوا هذا القانون.
والرد على هذا الاعتراض هو:
أولاً: إنّ كراهة النساء للمتعة منشؤها سوء التصرّف الصادر من الرجال المستهترين في هذا المجال، فيجب أن يردعهم القانون، وهذا ما سنبحثه في وقت لاحق.
ثانياً: إنّ الرغبة في الزواج المؤقّت بقدر الرغبة في الزواج الدائم أمر غير مستساغ؛ لأنّ ما يدعوا إلى الزواج المؤقّت هو عدم استعداد أو إمكانية الطرفين أو أحدهما للزواج الدائم.
3 - النكاح المنقطع لا ينسجم مع مكانة واحترام المرأة؛ إذ يمثّل نوعاً من استئجار الإنسان وإسباغ الشرعية على نفسه، إذ ممّا يخالف كرامة المرأة الإنسانية أنّ تضع نفسها تحت تصرّف رجل في مقابل نقود تقبضها منه.
هذا الاعتراض أعجب من سابقيه.
أولاً: ما علاقة الزواج المؤقّت - بالمواصفات التي فصّلناها - بالاستئجار؟
هل أنّ تحديد مدّة الزواج قد أخرجه من صورة الزواج إلى صورة الاستئجار؟
هل لأنّ مهراً معيّناً يجب أن يدفع صار الأمر أمر استئجار؟
فلو أنّ المرأة قد أسلمت نفسها للرجل دون أن يبذل لها شيئاً فهل تحفظ كرامتها الإنسانية بذلك؟
وسنتحدّث في فصل خاص فيما يتعلّق بالمهر.
لقد صرّح الفقهاء في القضاء ونظّم القانون المدني مواده كذلك على
أساس أنّ الزواج المؤقّت والزواج الدائم من حيث العقد متساويان وليس هناك أي اختلاف بينهما. فكلاهما زواج، وكلاهما يجب أن يتم بالألفاظ الخاصة بالزواج، ولو عقد النكاح المنقطع بصيغة الإجارة لكان باطلاً.
ثانياً: منذ متى أُلغي استئجار الإنسان؟
إنّ جميع الخيّاطين والحلاّقين وكل الأطباء والخبراء، وجميع موظفي الدولة من رئيس الوزراء حتى أدنى مستخدم، وجميع عمّال المصانع هم أُناس مستأجرون.
إنّ المرأة التي تعقد زواجاً مؤقّتاً مع رجل معيّن بمحض إرادتها ليست إنساناً مستأجراً ولم تفعل شيئاً خلاف الكرامة والشرف الإنساني. أمّا إذا أردت أن ترى المرأة الأجيرة، وأن تنظر إلى عبودية المرأة فسافر إلى أوروبا وأمريكا واذهب إلى شركات السينما لتعرف معنى المرأة الأجيرة؟ انظر كيف يعرضون للبيع حركات المرأة ووضعياتها وأمورها الخاصة، ومنزلتها الجنسية، التذاكر التي تقتنيها للسينما أو المسرح هي في الحقيقة أُجرة النساء المستأجرات. انظر هناك إلى المرأة التعيسة - من أجل أن تحصل على المال - لأي الأعمال تقدّم جسدها؟ إنّها يجب أن تتعلّم لمدّة طويلة أسرار الإثارة الجنسية بإشراف متخصّصين (شرفاء) وحاذقين، فتضع جسمها وروحها وشخصيّتها تحت تصرّف مؤسّسة مالية من أجل اجتذاب زبائن أكثر
للمؤسسة. الق نظرة على الملاهي والفنادق لترى الشرف الذي نالته المرأة، فمن أجل أجر حقير تحصل عليه، ومن أجل أن تضيف شيئاً إلى جيب الثري الفلاني انظر كيف تضع كل كرامتها وشرفها تحت تصرّف الزبائن. المرأة الأجيرة هي عارضة الأزياء المستأجرة في المتاجر الكبرى والتي تبذل شرفها وعِزّتها من أجل تطوير وتوسيع متاجرهم وأطماعهم.
المرأة الأجيرة هي المرأة التي - من أجل جذب العميل لإحدى المؤسسات الاقتصادية - تظهر على شاشة التلفزيون بألف شكل وشكل تمثيلاً وتصنيعاً كي تؤدّي واجبها الذي استؤجرت من أجله لصالح إحدى البضائع التجارية.
مَن ذا الذي لا يعلم اليوم أنّ جمال المرأة، وجاذبيتها الجنسية، وصوتها وفنّها وابتكارها وروحها وبدنها، وبالنتيجة شخصيتها تستخدم في الغرب كوسائل حقيرة وتافهة في خدمة الرأسمالية الأوروبية والأمريكية؟ وللأسف، فأنتم - علمتم أم لم تعلموا - تريدون أن تلقوا بالمرأة الإيرانية النجيبة الشريفة في هذه الهاوية. أنا لا أفهم لماذا تعتبر المرأة التي ترتبط بعقد زواج مؤقّت بشروط حرّة امرأة أجيرة، في حين أنّ امرأة تقوم في عرس أو حفلة ليلية بتمزيق حنجرتها بألف لحن ولحن أمام عيون ألف رجل جائع ومن أجل إرضاء شهواتهم الجنسية لكي تقبض أجراً معيّناً لا تُعتبر امرأة أجيرة؟
فهل الإسلام الذي منع الرجال عن مثل هذا الاستغلال للمرأة، ونبّه المرأة إلى خطورة هذا الأسر، ونهاها عن أن تجري وراء هذا الأمر وترتزق منه هو الذي حطّ من مكانة المرأة، أم أوروبا في النصف الثاني من القرن العشرين؟
وعندما يأتي اليوم الذي تعي فيه المرأة حقيقة ما يراد بها، وتكشف لها المصائد التي نصبها رجل القرن العشرين في طريقها، فستثور ضد هذا المكر وتصدّق حينذاك أنّ ملاذها الوحيد وحاميها الحقيقي الصادق هو القرآن وحده، وما ذلك اليوم - طبعاً - ببعيد.
مجلة (زن روز) أي (امرأة اليوم) في العدد 87 صفحة 8 كتبت تقريراً عن امرأة اسمها مرضية ورجل اسمه رضا تحت عنوان (المرأة الأجيرة) وشرحت تعاسة هذه المرأة المسكينة.
تبدأ القصة حسب ما يذكره رضا منذ خطبة المرأة. أي إنّ أطروحة الأربعين مقترحاً قد اتبعت لأوّل مرة وذهبت المرأة لخطبة الرجل. وبديهي أنّ القصة التي تبدأ بخطبة المرأة لرجل لا يمكن أن تكون لها نهاية أفضل من هذه النهاية.
أمّا طبقاً لما تقوله مرضية، فرضا رجل مهووس جنسياً، قاسي القلب، وقد أرادها زوجة دائمة له يرعاها ويرعى أطفالها إلاّ أنّه وبدون موافقة المرأة المسكينة استغلّها جنسياً بحجّة أنّه عقد عليها مؤقّتا ثم تخلّى عنها.
إنّ هذه التصريحات إذا كانت صحيحة، فالعقد باطل، رجل قاس اعتدى على امرأة غافلة، جاهلة بقانون الشرع والعرف وتجب معاقبته. وقبل أن يعاقب أمثال رضا يجب أن يُربّوا، وقبل أن يعاقب أمثاله أو يُربّوا يجب أن تبصر مرضية وأمثالها.
جناية منبعها قساوة رجل وغفلة امرأة، ما علاقتها بقانون الزواج المؤقت كي تقوم مجلة (زن روز) بالتزام جانب رضا، ثم تصب لومها على القانون، فلو أنّ قانون الزواج المؤقّت لم يكن موجوداً، أكان رضا - القاسي قلبه - يترك مرضية الغافلة لحالها؟
لماذا تتخلّون عن تربية وتوعية المرأة والرجل؟ تكتمون الحقوق والواجبات الشرعية عنهما، وتستغفلون النساء المسكينات فتظهرون لهن أنّ القانون الحامي والصادق للمرأة إنّما هو عدوّها وتطلبون منها أن تهدم بيدها ملاذها الوحيد؟
4 - النكاح المنقطع بما أنّه نوع من تعدّد الزوجات، وبما أنّ تعدّد الزوجات مرفوض فالنكاح المنقطع مرفوض أيضاً.
أمّا نوع الأفراد الذين شرع لهم النكاح المنقطع وما يتعلّق به من مسائل فسنبحثه بعد هذا الموضوع، كما سنبحث مسألة تعدّد الزوجات على حدة أيضاً بعون الله تعالى.
5 - النكاح المنقطع بما أنّه لا دوام له، فهو عش غير مناسب للأطفال الذين يتولّدون عنه؛ فيقرن النكاح المنقطع بولادة أطفال بلا معيل.
محرومين من حماية أب عطوف وأم حنون.
هذا الاعتراض أكّدت عليه مجلة (زن روز) كثيراً، لكن مع التوضيحات التي بينّاها لحد الآن لم يبق مجال للاعتراض. فقد ذكرنا في المقالة السابقة أنّ أحد الفوارق بين الزواج الدائم والمؤقّت هو مسألة الأطفال:
ففي الزواج الدائم لا يحق لأي من الزوجين أن يمنع النسل بدون رضا الزوج الآخر بخلاف الزواج المؤقّت حيث إنّ الطرفين حرّان في الزواج المؤقّت لا يجوز للمرأة أن تمنع تمتّع الرجل بها لكنّها تستطيع أن تمنع حملها منه بدون أن تنغّص متعته وهذا متيسّر اليوم عن طريق وسائل منع الحمل.
وعلى هذا، فإذا كان الزوجان في الزواج المؤقّت راغبين في إنجاب طفل وتحمّل مسؤولية رعايته وتربيته أنجباه. وبديهي أنّه من ناحية العاطفة الطبيعية لا فرق بين ولد الزوجة الدائمة وولد الزوجة المؤقّتة، ولو فرضنا أن الأب أو الأم امتنع عن أداء واجبه، أجبره القانون على ذلك، كما يتدخّل القانون عند حدوث الطلاق لمنع ضياع حقوق الأطفال. فإذا لم يكونا راغبين في الإنجاب - وكان غرضهما من الزواج المؤقّت إخماد جذوة الغريزة الجنسية - منعا الحمل.
وكما نعلم فإنّ الكنيسة تحرم منع الحمل، أمّا في نظر الإسلام فإنّ انعقاد الحمل منع منذ البداية وقبل تكوّن الجنين، فلا مانع، أمّا إذا انعقدت
النطفة وتكوّن الطفل فالإسلام لا يجيز إطلاقاً إعدامه.
وما يقوله فقهاء الشيعة (من أنّ الغرض من الزواج الدائم إنجاب الأطفال، والغرض من الزواج المؤقّت الاستمتاع وإخماد جذوة الغريزة الجنسية) يوضح هذا القصد.
انتقادات
انتقد كاتب الأربعين اقتراحاً النكاح المنقطع في العدد 87 من مجلة (زن روز) بما يلي:
أولاً: (إنّ موضوع قانون النكاح أو الزواج المنقطع مزعج إلى حد أنّ كتّاب قانون الزواج لم يتمكنوا من شرحه وتفصيله، وكأنّهم لم يرضوا لأنفسهم هذا العمل؛ ولذا نجدهم - ومراعاة للظواهر طبق المواد 1075 و1076 و1076 و1077 - ينسجون عبارات وألفاظ غير منسجمة. وإنّ منظّمي المواد القانونية المتعلّقة بالنكاح المنقطع (المتعة) كانوا ناقمين على عملهم إلى درجة أنّهم لم يعرفوا أساساً العقد المذكور، ولم يوضحوا شروطه ومراسيمه).
ثم يقوم السيد الكاتب بنفسه بتلافي نقص القانون المدني هذا، فيعرّف النكاح المنقطع بما يلي: (النكاح المذكور عبارة عن: قيام امرأة غير متزوّجة بوضع نفسها تحت تصرّف رجل لمدّة معيّنة ولو لعدّة ساعات أو دقائق من أجل قضاء شهوة وتمتّع وممارسة أعمال جنسية مقابل أخذ أجرة معيّنة ومحدودة).
ثم يقول: (من أجل الإيجاب والقبول في عقد النكاح المذكور، ذكرت في كتب فقه الشيعة ألفاظ عربية خاصة لم يشر إليها القانون المدني، فيظهر أنّ القانون يعتبر العقد واقعاً باستعمال أي لفظ يدل على القصد المذكور (أي قصد الإجارة أو أخذ الأجرة) حتى لو لم يكن باللغة العربية).
فالسيد الكاتب يرى:
أ - إنّ القانون المدني لم يعرف النكاح المنقطع ولم يوضح شروطه.
ب - ماهية النكاح المنقطع هي أن تؤجّر امرأة نفسها لرجل مقابل مبلغ معيّن.
ج - من وجهة نظر القانون المدني أنّ كل لفظ يدل على مفهوم إجارة المرأة تتفوّه به المرأة يُعدّ إيجاباً وقبولاً لنكاح منقطع.
إنّني أدعو السيد الكاتب إلى مطالعة القانون المدني مرّةً ثانية، وأن يطالعه بدقّة، كما أرجو من قرّاء مجلّة (زن روز) أن يحصلوا بصورةٍ ما على نسخة من القانون المدني ويطالعوا الفقرات التالية:
في القانون المدني خصّص الفصل السادس من كتاب النكاح، للنكاح المنقطع ولم يضم أكثر من ثلاث جمل بسيطة.
الأُولى: إنّ النكاح المؤقّت منقطع لمدّة معيّنة.
الثانية: إنّ مدّة النكاح المنقطع يجب أن تعيّن بوضوح.
الثالثة: إنّ أحكام المهر والإرث في النكاح المنقطع هي نفس الأحكام المذكورة في الفصول الخاصّة بالمهر والإرث.
إنّ كاتب المقترحات الأربعين المحترم تخيّل أنّ كل ما ذكر في الفصول الخمسة الأُولى من كتاب النكاح تتعلّق بالنكاح الدائم، وأنّ هذه الجمل الثلاث هي كل ما قيل حول النكاح المنقطع. غفل عن أنّ جميع مواد الفصول الخمسة مشتركة بين النكاح الدائم والمنقطع عدا ما خصص مثل المادة 1069، وما اختص بالطلاق، فمثلاً جاء في المادة 1062 ما يلي: (يقع النكاح بالإيجاب والقبول بالألفاظ الدالة صراحة على قصد الزواج). فهذا مثلاً لا يقتصر على الزواج الدائم بل يشمل النوعين.
والشروط التي ذُكرت والواجب توفّرها في العاقد أو العقد أو الزوجين كذلك تتعلّق بالزواج المنقطع والدائم كليهما. فإذا كان القانون المدني لم يعرف الزواج المنقطع فلأنّه لا يحتاج إلى تعريف. كما أنّه لم يعرف الزواج الدائم لغناه عن التعريف. إنّ القانون المدني قد اعتبر أي لفظ صريح دال على الزواج ووقوع الزوجية كافياً للعقد سواء في الزواج الدائم أو المنقطع. أمّا إذا كانت للفظ دلالة أخرى غير الزوجية كالمعاوضة والمعاملة والكروة والإجارة، لم يصح عقد الزواج، دائماً كان أو منقطعاً.
إنّني بموجب هذا الذي ذكرت الآن أتعهّد - فيما إذا قامت مجموعة
من القضاة الأفاضل والخبراء القانونيين، وهم كثيرون في المحاكم بالإقرار بصحّة الاعتراضات التي أوردت حول القانون المدني - منذ الآن بالامتناع عن الاعتراض على كل ما يكتب في مجلة (زن روز).
الزواج المؤقّت ومسألة بيت الحريم (3)
من المواضيع التي يثيرها الغرب ضد الشرق ويهيّئ من أجلها أفلاماً ومسرحيات مسألة إنشاء بيوت الحريم التي يضم تاريخ الشرق - وللأسف - نماذج كثيرة منها.
لقد كانت حياة بعض خلفاء وسلاطين الشرق نموذجاً كاملاً لهذه السيرة، ويعد إنشاء بيت الحريم صورة واضحة للهوس الجنسي وعبادة الهوى عند الرجل الشرقي.
يقولون: إنّ السماح بالزواج المؤقّت يساوي السماح بتشكيل بيوت الحريم التي تُعدّ نقطة ضعف وأمراً مخجلاً للشرق أمام الغرب. بل يُعدّ مساوياً لإطلاق حرّيّة الهوس الجنسي والعبث، وهو مهما كان شكله ومظهره ممّا ينافي الأخلاق والتقدّم، ويُعدّ من عوامل السقوط الحضاري.
وقد قيل نفس هذا الكلام عن تعدّد الزوجات. فقد فسّروا جواز تعدّد الزوجات على أنّه جواز تشكيل بيوت الحريم.
إنّنا سنبحث مسألة تعدّد الزوجات في فصل خاص. أمّا هنا فسنقصر بحثنا على الزواج المؤقّت فقط.
هذه المسألة يجب بحثها من جهتين:
الأُولى: ماذا كانت دواعي إنشاء بيت الحريم من الناحية الاجتماعية؟ وهل كان لقانون الزواج المؤقّت أثر في إنشائها في الشرق أم لا؟
الثانية: هل كان تشريع قانون الزواج المؤقّت بقصد أن يكون وسيلة غير مباشرة للهوس الجنسي وتشكيل بيوت الحريم من قِبَل البعض أم لا؟
العوامل الاجتماعية لتشكيل بيوت الحريم
أمّا القسم الأوّل - فإنّ بيت الحريم وُجد نتيجة لتظافر عاملين:
العامل الأوّل: هو تقوى وعفاف المرأة، أي أنّ الظرف الأخلاقي والاجتماعي للمحيط كان لا يسمح للمرأة المرتبطة بعلاقة جنسية برجل معيّن أن تكوّن لها علاقات برجال آخرين. ففي مثل هذا الظرف يجد الغني العابث وسيلته الوحيدة للتبذّل قد انحصرت في أن يجمع عدّة نساء في مكان قريب منه ليكنّ في متناول يده؛ هذا المكان هو بيت الحريم.
وبديهي أنّه حين لا تكون الظروف الأخلاقية والاجتماعية ملزمة
للمرأة بالتقوى والعفاف، وتسلم المرأة نفسها مجاناً وبكل يسر وسهولة لأي رجل تشاء ويستطيع الرجل في أي لحظة أن يعبث مع أي امرأة أراد، وحين توفّر إمكانية ممارسة الجنس بحرية في كل زمان ومكان، حينذاك لا يكلّف الرجال العابثون أنفسهم عناء تشكيل بيت الحريم الذي يحمّلهم النفقات الباهضة.
العامل الثاني: هو انعدام العدالة الاجتماعية، فحين تفتقد العدالة الاجتماعية ويصبح البعض غارقاً في النعيم والآخر في البؤس والفقر؛ يحرم عدد كبير من الرجال من إمكانية تكوين عائلة والحصول على زوجة مناسبة في الوقت الذي يتزايد فيه عدد النساء العازبات ممّا يهيّئ الجو لتشكيل بيوت الحريم.
فلو أنّ العدالة الاجتماعية توفّرت وتمكّن كل رجل من اختيار زوجة وتشكيل عائلة، فستختص كل امرأة بزوجها وينتفي أساس وجود العبث والهوس وتشكيل بيوت الحريم.
إذاً ما مقدار الزيادة في عدد النساء على الرجال لكي يتمكن كل رجل - أو على الأقل كل رجل غني - من تشكيل بيت حريم له حين يكون كل الرجال متزوجين؟
إنّما عادة التاريخ أن يعرض قصص بيوت الحريم في قصور الخلفاء والسلاطين، ويستعرض مجونهم وعبثهم لحظة بلحظة، لكنّه يسكت إزاء ما يقابل ذلك من الحرمان والفقر والحسرات وتبخّر الآمال
تحت تلك القصور حيث يشقى الكثيرون ولا تسمح لهم ظروفهم الاجتماعية بالفوز بزوجة. وان عشرات بل مئات النساء الموجودات في بيوت الحريم إنّما يمثّلن حقّاً طبيعياً لعدد من المحرومين والبؤساء الذين قضوا كل أعمارهم عزّاباً.
ومن المسلّم به أن لو كان مبدأ العفاف يحكم المجتمع، لكانت التقوى أمراً لازماً للمرأة، عندها لا ينطفئ الظمأ الجنسي إلاّ في ظل الزواج (دائماًَ أو مؤقّتاً) ومن ناحية أخرى، تختفي المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ويتيسّر لجميع الأفراد التمتّع بحقّهم الطبيعي - كبشر - في الزواج ويصبح تشكيل بيوت الحريم أمراً مستحيلاً أو ممتنعاً.
إنّ نظرة سريعة إلى التاريخ تظهر أنّ قانون الزواج المؤقّت لم يكن له أدنى تأثير على تشكيل بيت الحريم؛ فإنّ خلفاء بني العبّاس والسلاطين العثمانيين الذين اشتهروا أكثر من غيرهم بهذه المسألة لم يكن أحد منهم شيعيّاً ليعمل بقانون الزواج المؤقّت.
وإنّ السلاطين الشيعة بالرغم من اتخاذهم هذا القانون مبرّراً لأعمالهم إلاّ أنّهم لم يبلغوا مبلغ الخلفاء العبّاسيين والسلاطين العثمانيين.
وهذا بذاته يفصح عن أنّ هذه الوضعية كانت نتيجة أسباب اجتماعية أخرى.
هل جاء تشريع الزواج المؤقّت لتأمين العبث الجنسي؟
القسم الثاني: لو شككنا في أي شيء، لما شككنا في أنّ الأديان
السماوية عموماً قد جاءت مخالفة للعبث والهوى، حتى وصل الأمر بأتباع أكثر الأديان أن يقاوموا الهوى والعبث بصورة رياضات شاقّة، وأنّ من مبادئ الإسلام الواضحة والمسلّم بها محاربة العبث. وقد جعل القرآن الكريم عبادة الهوى كعبادة الأصنام، وفي الإسلام اعتبر الإنسان (الذواقة) ملعوناً مبغوضاً عند الباري تعالى، و(الذواقة) هو الإنسان الذي يحب الاستمتاع بمختلف النساء على سبيل التذوّق. وسنذكر في بحث الطلاق الأدلة الإسلامية المتعلّقة بهذه النقطة.
إنّ ميزة الإسلام عن الشرائع الأخرى أنّه يعارض التصوّف والرهبانية، ولا يعني ذلك أنّه يبيح العبث في المقابل، بل إنّ رأي الإسلام وهو أنّ جميع الغرائز - سواء منها الجنسية وغيرها - يجب أن تشبع في حدود الحاجة، ولكنّه لا يجيز أن يقوم الإنسان بإيقاد نار الغرائز لتصبح عطشاً لا يُروى. وعلى هذا الأساس، فكل شيء اتخذ لون العبث أو الظلم، فليس من الإسلام في شيء.
ممّا لا شك فيه أنّه لم يكن هدف مشرع الزواج المؤقّت جعله وسيلة مجون وتكوين بيوت حريم بيد العابثين وسبب بؤس وتشرّد امرأة وعدّة أطفال.
وقد ورد عن أئمّة الدين الحثّ والترغيب في الزواج المؤقّت؛ ولذلك فلسفة خاصة سأوضّحها عمّا قريب.
بيت الحريم في عالم اليوم
ولنر الآن كيف تصرّف عالم اليوم تجاه تشكيل بيوت الحريم. إنّ عالم اليوم قد ألغى عادة بيت الحرم، واعتبرها عملاً قبيحاً وقضى على مسبّبها لكن على أيّ مسبّب قضى، هل قضى على المفارقات الاجتماعية ودفع بالشباب نتيجة لذلك نحو الزواج، وبهذه الطريقة قضى على مسبّبات إنشاء بيت الحريم؟
كلاّ، بل فعل شيئاً آخر، إنّه حارب السبب الأول (أي عفاف وتقوى المرأة) وأدّى بذلك لجنس الرجل أعظم خدمة. فتقوى المرأة وعفافها بمقدار ما يمنحان المرأة قيمة إنسانية ويجعلانها عزيزة كريمة يقفان حائلاً وسدّاً أمام الرجل بنفس المقدار. إنّ عالم اليوم قد عمل على ألاّ يحتاج عابثوا القرن العشرين، إلى إنشاء بيوت الحريم بما تكلّف من أموال وجهود. فبالنسبة لرجل هذا القرن وببركة الحضارة الغربية أصبح كل مكان بيتاً للحريم؛ فرجل هذا القرن لا يحتاج إلى مثل أموال هارون الرشيد والفضل بن يحيى البرمكي ولا سلطتهما كي يتمتّع بنفس القدر من جنس النساء على اختلاف الألوان والأنواع.
فبالنسبة لرجل هذا القرن يكفي أن يملك سيّارة ومرتّباً لا يزيد على ألفين أو ثلاثة آلاف تومان(1) ليصبح ماجناً يعبث ويلهو بجنس النساء
____________________
(1) التومان: عملة إيرانية تساوي 8/1 الأمريكي بالسعر الرسمي.
بشكل لم يكن يحلم به هارون الرشيد نفسه، فجميع الفنادق والمطاعم والمقاهي صارت بيوت حريم لرجل القرن العشرين.
إنّ شابّاً مثل (عادل كوتوالى) يقول اليوم بصراحة تامة إنّه يملك اثنتين وعشرين معشوقة بأشكال مختلفة، فماذا يريد أحسن من هذا رجل هذا القرن؟ إنّ رجل اليوم لم يفته من بيوت الحريم - ببركة الحضارة الغربية - إلاّ النفقات الباهضة والجهود المضنية.
ولو أنّ بطل ألف ليلة بُعث في هذه العصر ورأى الوسائل المتنوّعة للعبث ومعاشرة النساء ورخص ومجانية المرأة اليوم، لما فكّر في إنشاء بيوت الحريم بتلك الميزانية الضخمة والجهود المضنية، ولشكر شعوب الغرب الذين أغنوه عن تشكيل هذه البيوت، ولأعلن إلغاء تعدّد الزوجات والزواج المؤقّت لما تضعه على كواهل الرجال من مسؤوليات والتزامات تجاه النساء.
فإذا سألتم الآن قائلين قد عرفنا الفائز في لعبة الأمس ولعبة اليوم، فمَن الخاسر فيها؟ بكل أسف أُجيب أن الذي خسر أمس واليوم هو ذلك الموجود الضعيف السريع التصديق، الطيّب القلب والذي يسمّونه جنس المرأة.
منع الخليفة للزواج المؤقّت
يختص الفقه الجعفري بالزواج المؤقّت، أمّا باقي المذاهب الإسلامية فلا تجيزه، وأنا لا أميل أبداً إلى أن أثير نزاعاً بين الشيعة
والسنّة. إنّما أذكر هنا شيئاً مختصراً عن تاريخ هذه المسألة.
يجمع المسلمون على أنّ الزواج المؤقّت كان جائزاً في صدر الإسلام. وقد أجازه الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله)، في بعض أسفاره - حيث كان المسلمون يعانون البعد عن زوجاتهم - كما يتفق المسلمون كذلك على أنّ الخليفة الثاني في زمن خلافته قد حرّم النكاح المنقطع. وعبارته المعروفة المشهورة هي: (متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء)(1) .
ويعتقد فريق من أهل السنّة أنّ الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله) نفسه قد حرّم النكاح المنقطع في أواخر أيامه وما منع الخليفة إلاّ إعلان لمنعها السابق من قِبَل النبي (صلّى الله عليه وآله)، إلاّ أنّ العبارة التي وردت عن نفس الخليفة تدل على خلاف ذلك.
التفسير الصحيح لهذه المسألة - كما بيّنه العلاّمة كاشف الغطاء - هو أنّ الخليفة قد أعطى لنفسه الحق في منع هذا الأمر؛ لأنّه تصوّر أنّ ذلك داخل ضمن صلاحيات ولي أمر المسلمين، فكل حاكم وولي أمر يمكن أن يمارس صلاحياته حسب مقتضى العصر في مثل هذه المواقف.
____________________
(1) وأخرج الطبراني في (المستبين) عن عمر أنّه قال:
(ثلاث كنّ على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنا محرّمهن ومعاقب عليهن، متعة الحج ومتعة النساء...) (الغدير، ج6، ص213).
وبتعبيرٍ آخر، إنّ نهي الخليفة كان نهياً سياسياً لا شرعياً وقانونياً... فممّا يفهم من التاريخ، أنّ الخليفة في فترة حكمه، لم يخف قلقه من تفرّق الصحابة في الأقطار المفتوحة حديثاً واختلاطهم بالشعوب الحديثة العهد بالإسلام. وقد منع - مدّة حياته - خروجهم من المدينة المنورة، لئلاّ يختلط دمهم بالمسلمين الجدد قبل أن يتربّى الأخيرون تربية إسلامية عميقة، فقد كان لا يرضيه ذلك ويعدّه خطراً على الأجيال القادمة، وبديهي أنّ هذا كان سبباً مؤقّتاً لا أكثر. والسبب الذي دعا المسلمين في ذلك الوقت إلى قبول تحريم الخليفة هو أنّهم تلقّوه على أنّه مصلحة سياسية مؤقّتة لا قانوناً دائماً، وإلاّ فليس ممكناً أن يقول خليفة العصر قال النبي كذا وأنا أقول كذا ويرضى الناس بقوله.
لكن - ونتيجة لأحداث معيّنة وقعت بعد ذلك - أخذت سيرة الخلفاء الأوائل وخصوصاً الخليفتين الأولين على أنّها شيء ثابت، ثم أدّى التعصّب إلى أن تتخذ سيرتهما شكل القانون؛ لذا فالاعتراض الذي يرد هنا إنّما يرد على إخواننا أهل السنّة أكثر ممّا يرد على نفس الخليفة. فالخليفة حرم النكاح المنقطع تحريماً سياسياً مؤقّتاً (كتحريم التبغ(1) الذي وقع في هذا القرن). فيجب ألاّ يعتبره المسلمون أبديّاً.
بديهي أنّ نظرة العلاّمة كاشف الغطاء لم تتناول ما إذا كان تدخّل
____________________
(1) تحريم التنباك المشهور في إيران، بفتوى المجتهد المرجع آية الله الشيخ محمد حسن الشيرازي.
الخليفة أصلاً صحيحاً أم لا! كما لم تتناول ما إذا كانت مسألة الزواج المؤقّت من المسائل التي يمكن لولي المسلمين الشرعي أن يحرّمها ولو لمدّة أم لا؟ إنّما بحث في أنّ الحادثة في بداية الأمر كانت بهذا الاسم وهذا العنوان ممّا لم يواجه باعتراض عموم المسلمين، وعلى كل حال، فإنّ نفوذ وشخصية الخليفة وتعصّب الناس لسيرته وإدارته كانا سبباً في نسيان هذا القانون وترك هذه السنّة المكمّلة للزواج الدائم والتي يؤدّي تعطيلها إلى مشاكل كبيرة.
وهنا قام الأئمّة الأطهار الذين هم حرّاس هذا الدين المبين بالترغيب في هذه السنّة والتشجيع على القيام بها من أجل ألاّ يطويها النسيان كسنّة إسلامية، وقد عدّ الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) موضوع المتعة من المواضيع التي لا تراعى التقيّة في بيانها.
وهنا ظهرت حكمة ثانوية أُضيفت إلى الحكمة الأوّلية في تشريع النكاح المنقطع، وتلك هي السعي لإحياء (سنّة متروكة). وفي نظري أنّ الأئمة الأطهار حين نهوا الرجال المتزوّجين عن المتعة - بالنظر إلى حكمتها الأولية - أرادوا أن يبيّنوا أنّ هذا القانون لم يوضع للرجال الذين لا يحتاجونه. فنجد الإمام الكاظم (عليه السلام) يقول لعلي بن يقطين ما مفاده: ما أنت ونكاح العبيد وقد أغناك الله عنه.
بينما يقول لآخر ما يفيد أنّ هذا الأمر جائز لمن لم يغنه الله عنه بزوجة، وأمّا مَن له زوجة فلا يقدم على هذا العمل إلاّ حين يكون بعيداً
عن زوجته. أمّا ترغيب وتشجيع عموم الناس على ممارسة هذا العمل فقد كان للحكمة الثانوية أي (إحياء السنّة المتروكة)؛ إذ إنّ ترغيب المحتاجين إليها فقط غير كافٍ لإحيائها كسنّة، وهذا الأمر واضح في أخبار وروايات الشيعة.
وعلى كل حال فإنّ من المسلّم به أنّ هدف مشرع هذا القانون وهدف الأئمّة الأطهار من الترغيب في ممارسته لم يكن لغرض العبث وإشباع الهوى وإقامة بيوت الحريم للمبتذلين، ولا لأجل أن يكون سبباً في بؤس الساذجات من النساء وحرمان الأطفال من الأبوّة.
حديث عن علي (عليه السلام)
كتب السيد المهدوي كاتب المقترحات الأربعين في العدد 87 من مجلة (زن روز) ما يلي:
نقل في كتاب الأحوال الشخصية للشيخ محمد أبي زهرة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: (لا أعلم أحداً تمتّع وهو محصن إلاّ رجمته بالحجارة).
وقد ترجم السيد المهدوي هذه العبارة كما يلي:
(كما علمت بشخص غير لائق تمتع إلاّ حددته حدّ المحصن ورجمته بالحجارة).
أولاً: إذا كنّا نقبل قول أمير المؤمنين (عليه السلام) فلماذا نضرب عرض الحائط
كل هذه الروايات المروية عنها في كتب الشيعة وغير الشيعة في باب المتعة، ونقتصر على التمسّك برواية، واحدة رواها أحد علماء أهل السنّة وبسند غير واضح؟ فإنّ من أقوال أمير المؤمنين (عليه السلام) القيّمة ما معناه (لو لم ينه عمر عن المتعة، لم يزن إلاّ شقي) أي ما زنا إلاّ الشقي المنحرف.
ثانياً: إنّ العبارة الأُولى تعني أنّه هدّد المحصن (أي المتزوّج) بالرجم، فلا أدري لماذا ترجم السيد المهدوي كلمة (المحصن) بـ (غير المؤهّل) وعلى هذا، فإنّ قصد الرواية أنّه لا يحق للمتزوّجين أن يتمتّعوا، ولو كان المقصود أنّه ليس من حق أيّ شخص مهما كان أن يتمتّع لأصبح قيد (وهو محصن) لغواً؛ إذاً فهذه الرواية إذا صحّت فهي تؤيّد ما يلي:
(إنّ قانون المتعة قد شرّع للأفراد المحتاجين إلى النساء، وهم العزّاب أو الذين يعيشون بعيداً عن زوجاتهم).
فهذه الرواية إذاً دليل على جواز الزواج المؤقّت لا على حرمته.
الفصل الثالث
الاستقلال الاجتماعي للمرأة
الاستقلال في تقرير المصير
جاء في المرسل عن ابن عبّاس (رض) أنّ جارية بكراً جاءت النبي (صلّى الله عليه وآله) فقالت:
(إنّ أبي زوّجني من ابن أخ له ليرفع خسيسته وأنا له كارهة.
- أجيزي ما صنع أبوك.
- لا رغبة لي فيما صنع أبي.
- فاذهبي فانكحي مَن شئت.
- لا رغبة لي عن ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء في أُمور بناتهم شيء).
أورد هذه الرواية الشهيد الثاني في المسالك، وصاحب الجواهر(1) ، وغيرهم من الفقهاء نقلاً عن العامّة.
في الجاهلية العربية - كما في الجاهلية غير العربية - كان الآباء يعطون لأنفسهم الولاية المطلقة على البنات والأخوات، وحتى الأُمّهات في بعض الأحيان، ولا يعترفون لهنّ بأيّ حق في اختيار الزوج، وهذا
____________________
(1) جواهر الكلام، ج29، ص177، عن سنن ابن ماجه، ج1، ص: 578.
الاختيار - في تصوّرهم - حق مطلق للأب أو الأخ وعند عدم وجودهما، فالولاية للعم، وقد بلغت الولاية على النساء في التزويج إلى حدّ أنّ بعض الآباء كانوا يزوّجون بناتهم قبل ولادتهن! فإذا وُلدت البنت وجدت مَن ينتظرها ليأخذها زوجة له بعد أن تكبر.
التزويج قبل الولادة
في آخر حجّة حجّها رسول الله وبينما كان راكباً وبيده سوط اعترض طريقه رجل وقال له:
- أشكو إليك يا رسول الله.
- قل
- قبل سنوات وفي الجاهلية اشتركت مع طارق بن مرقع في أحدى المعارك فاحتاج طارق في أثناء القتال إلى سهم فنادى: مَن يعطيني سهماً ويأخذ أجره؟ فتقدّمت منه وقلت له: وما أجره؟ قال: أعدك أن أعطيك أول فتاة تولد، فقبلت وأعطيته السهم. ومرت الأيام والسنون حتى علمت أخيراً أنّ في بيته فتاة ناضجة، فذهبت إليه وذكرته بالقضية وطالبته بالوفاء بالوعد الذي قطعه، لكنّه نكص وأخذ يتذرّع بالحجج وطالبني بمهر وقد جئتك يا رسول الله لأرى هل الحق معه أم معي؟
- وما عمر الفتاة؟
- إنّها كبيرة، وقد ابيض بعض شعر رأسها.
- ليس الحق معك ولا مع طارق، انصرف إلى عملك وخلّ سبيل
هذه الفتاة المسكينة.
تحيّر الرجل وبقي ينظر إلى الرسول (صلّى الله عليه وآله) وهو غارق في التفكير في أنّه أي حكم جائر هذا الذي أصدره الرسول (صلّى الله عليه وآله)؟... أليست للآباء ولاية على بناتهم؟ ولماذا يحق للأب أن يأخذ مهراً جديداً ويعطي ابنته برضاه؟
لكنّ الرسول (صلّى الله عليه وآله) أدرك من نظراته الحائرة ما يدور في ذهنه فقال له: (اعلم أنّك إن اتبعت قولي لن تأثم أنت ولن يأثم رفيقك طارق).
مبادلة البنات
أمّا نكاح الشغار فقد كان مظهراً آخر من مظاهر الولاية المطلقة للآباء على بناتهم، ونكاح الشغار هو مبادلة البنات؛ وذلك بأن يتفق رجلان على أن يزوّج كل منهما ابنته للآخر، وتكون كل منهما مهراً بالنسبة للأُخرى، لقد حرّم الإسلام هذا النوع من الزواج واعتبره باطلاً.
الرسول (صلّى الله عليه وآله)، منح ابنته الزهراء حرّية اختيار الزوج
لقد زوّج الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله) عدداً من بناته دون أن يصادر حقّهن في الاختيار، وعندما خطب علي بن أبي طالب (عليه السلام) الزهراء (عليها السلام) من أبيها قال له الرسول (صلّى الله عليه وآله) إنّ رجالاً آخرين كانوا قد طلبوا يدها، وأنّه (صلّى الله عليه وآله) سوف يأخذ رأيها في الخاطب الجديد.
وذهب الرسول (صلّى الله عليه وآله) إلى ابنته الزهراء وأطلعها على الموضوع، بيد أنّ الزهراء لم تعرض هذه المرّة كما كانت تفعل من قبل بل عبّرت عن
رضاها بسكوتها فخرج الرسول (صلّى الله عليه وآله) من عندها وهو يكبّر.
النهضة الإسلامية للمرأة كانت نهضة بيضاء
لقد قدّم الإسلام أعظم الخدمات لجنس المرأة، ولم يكن سلب الولاية المطلقة للآباء على بناتهم الخدمة الوحيدة التي قدّمها الإسلام في هذا الميدان. لقد منحها حريتها وشخصيتها واستقلالها الفكري واعترف بحقوقها الطبيعية، لكن هناك فرقين أساسيّين بين ما فعله الإسلام في هذا السبيل وبيّن ما يجري في بلاد الغرب ويقلّده الآخرون هنا.
الأوّل: من وجهة نظر علم النفس إذ صنع الإسلام المعجزات في هذا المجال، وسوف نبحث هذا الموضوع في الفصول القادمة ونعطي نماذج له.
الثاني: يتمثّل في أنّ الإسلام - وهو يعرف النساء بحقوقهن الإنسانية، ويعترف لهن بشخصيتهن وحريتهن واستقلالهن - لم يدعهن إلى التمرّد والعصيان والطغيان ضد جنس الرجال، ولم يزرع في نفوسهن التشاؤم منهم.
لقد كانت النهضة الإسلامية النسوية نهضة بيضاء، ولم تكن سوداء ولا حمراء ولا زرقاء ولا بنفسجية؛ فلم يقض الإسلام على احترام البنات لآبائهن والنساء لأزواجهن، ولم يزعزع أسس البناء العائلي، ولم يفسد نظرة المرأة إلى الحياة الزوجية والأُمومة وتربية الأطفال، ولم
يجعل المرأة متاعاً للعزّاب الذين يبحثون عن صيد، ولم ينتزع النساء من أحضان أزواجهن والفتيات من كنف أُمّهاتهن وآبائهن ويسلّمهن إلى المترفين من أصحاب المناصب العليا، لم يفعل الإسلام ما يؤدّي إلى ارتفاع صيحات الاستغاثة إلى السماء من الجانب الآخر من المحيط داعية بالويل والثبور لانهيار كيان العائلة المقدّس وفقدان الاطمئنان الأبوي: ماذا نفعل مع كل هذا الفساد؟ ماذا نفعل مع قتل الأطفال وإسقاط الأجنّة؟
وبنسبة الـ (40%) من الولادات غير الشرعية لمواليد يعرف آباؤهم، وأُمّهات لا يرغبن في تربيتهم؛ لأنّهم لم يلدنهم في بيوت يظلّلها حنان الآباء، فيرمين بهم في المؤسسات الاجتماعية وتنقطع علاقتهن بهم إلى الأبد.
إنّ بلادنا محتاجة إلى نهضة نسائية... نهضة إسلامية بيضاء، لا نهضة سوداء على الطريقة الأوروبية... نهضة لا تتدخّل فيها الأيدي الدنسة لعباد الشهوات من الشبّان... نهضة تنبع فعلاً من التعاليم السامية ولا تسخر القوانين الإسلامية للأهواء والشهوات باسم تغيير القانون المدني، نهضة تقوم أوّلاً بالدراسة المنطقية والمعمقة التي تهدف إلى معرفة مدى تطبيق التعاليم الإسلامية في المجتمعات التي تطلق على نفسها اسم الإسلام.
وإذ وفقنا الله تعالى لإكمال هذه المقالات وبحث النقاط الضرورية، فسوف نعرض نتائج ومكاسب النهضة الإسلامية للمرأة وسوف تجد
المرأة الإيرانية أنّ باستطاعتها القيام بنهضة حديثة - مستقلّة ومنطقية - تنبع من فلسفتها المستقلّة التي ظهرت قبل أربعة عشر قرناً من غير أنّ تمدّ يد الضراعة إلى عالم الغرب.
إذن الأب
المسألة المطروحة حول ولاية الآباء على بناتهم هي: هل تشترط موافقة الأب في زواج ابنته البكر أم لا؟
من وجهة النظر الإسلامية هناك عدّة نقاط لا جدال فيها:
يتمتّع الابن والبنت - كلاهما - بالاستقلال الاقتصادي؛ إذ يحق لكل منهما التصرّف في أمواله أو الاحتفاظ بها إذا كان بالغاً عاقلاً ورشيداً أيضاً، أي ناضجاً فكرياً من وجهة نظر المجتمع، وليس للأب أو الأم أو الزوج أو الأخ، أو أي شخص آخر حق الإشراف عليهما، أو التدخّل في شؤونهما من هذه الناحية.
وإذا بلغ الفتى سن الرشد وكان عاقلاً رشيداً فإنّه يملك أمره، ولا يحق لأحد أن يفرض عليه شيئاً في موضوع زواجه.
أمّا الفتاة فإنّها إن كانت ثيّباً فهي أيضاً تملك أمرها كما هو الحال بالنسبة للفتى. ولكن ما هو حكم الفتاة البكر التي تريد الاقتران برجل لأوّل مرّة؟
لا شك في أنّه ليست لأبيها عليها سلطة مطلقة، ولا يحق له أن
يزوّجها من يشاء بدون رضاها، فقد رأينا كيف أنّ الرسول (صلّى الله عليه وآله) كان صريحاً في جوابه للفتاة التي زوّجها أبوها بدون أن يأخذ رأيها، إذ قال (صلّى الله عليه وآله) لها: بأنّها تستطيع - إن لم تكن راغبة بذلك - الزواج من غيره. إنّ الاختلاف الموجود بين الفقهاء، يدور حول مسألة: ألاّ يحق للفتيات الباكرات الزواج بدون موافقة آبائهن؟ أم أنّ موافقة الآباء ليست شرطاً في صحّة الزواج في أيّ حالٍ من الأحوال؟
وهناك مسألة أخرى لا خلاف فيها أيضاً وهي: إذا لم يأذن الأب بزواج ابنته ولم يكن لديه سبب معقول، فإنّ ولايته تسقط ويحق للبنت أن تختار الزوج المناسب لها باتفاق كافّة الفقهاء.
أمّا هل تعتبر موافقة الأب شرطاً أم لا؟ فقد قلنا بأنّ هناك اختلافاً بين الفقهاء حول هذه المسألة، ولعلّ أغلبهم - وخصوصاً المتأخّرين - لا يعتبرون موافقة الأب شرطاً، بينما يرى بعضهم أنّه شرط. وقانوننا المدني يتقيّد برأي هذا البعض؛ وهو الرأي الأقرب للاحتياط.
وحيث إنّ هذه المسألة ليست من القضايا الإسلامية الثابتة، فسوف لا أتناولها بالبحث من وجهة النظر الإسلامية، ولكنّي أرى ضرورة بحثها من زاوية اجتماعية؛ إضافة إلى رأيي الشخصي الذي أرى فيه أنّ قانوننا المدني قد نحا المنحى الصحيح في هذه القضية.
الرجل عبد الشهوة والمرأة أسيرة المحبّة
إنّ فلسفة منع الفتاة، أو على الأقل عدم تحبيذ زواجها من دون
موافقة أبيها، تكمن في اعتبار الفتاة قاصرة، أو أقل من الرجل في النضج الاجتماعي؛ إذ لو كان الأمر كذلك لما كان هناك فرق بين الثيّب والبكر لتكون الثيّب البالغة من العمر ستة عشر عاماً مستغنية عن موافقة الأب، بينما تحتاج البكر البالغة ثمانية عشر عاماً إلى موافقته. وإذا كان الإسلام يعتبر الفتاة قاصرة عن إدارة أمورها فلماذا أعطى البنت البالغة الرشيدة استقلالها الاقتصادي وصحّح معاملاتها المالية حتى لو بلغت الملايين، دون الحاجة إلى موافقة الأب أو الأخ أو الزوج؟ إنّ لهذا الأمر فلسفة لا يمكن إغفالها حتى لو تجاوزنا الأدلة الفقهية. وينبغي أن نقول لواضعي القانون المدني: نِعم ما صنعتم.
إنّ هذا الموضوع لا يرتبط بقصور امرأة وعدم نضجها العقلي، ولكنّه يتعلّق بجانب من التركيب النفسي للرجل والمرأة، بروح الاصطياد التي يتمتّع بها الرجل من جهة، وسرعة الاطمئنان التي تتميّز بها المرأة في مقابل وفاء وإخلاص الرجل من جهةٍ أخرى.
الرجل عبد الشهوة والمرأة أسيرة المحبّة، إنّ الذي يهز الرجل ويجرّه إلى المنزلق ويقضي عليه هو الشهوة، بينما المرأة - باعتراف علماء النفس - أشدّ من الرجل صبراً وثباتاً أمام الشهوة، لكن الذي يأسر المرأة أو يقضي عليها هو سماعها نغمة المحبّة والصفاء والعشق والوفاء من فم الرجل، فهنا تكن سرعة اطمئنان المرأة.
إنّ المرأة مادامت بكراً - لم يمس جسدها صابون الرجال - فإنّها
تصدّق حديث الحب من الرجل بسهولة.
لا أدري هل قرأتم نظريات عالم النفس الأمريكي البروفيسور (ريك) المنشورة في العدد (90) من مجلة (زن روز) أي (امرأة اليوم) بعنوان (ليس العالم واحداً بالنسبة للرجل والمرأة)؟ إنّه يقول: (خير جملة يمكن أن يقولها رجل لامرأة هي: عزيزتي إنّني أحبّك). ويقول أيضاً: (تتلخّص السعادة بالنسبة للمرأة في امتلاكها قلب رجل والاحتفاظ به طول عمرها).
إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) - هذا العالم النفساني الإلهي - أوضح هذه الحقيقة قبل أربعة عشر قرناً إذ قال: (قول الرجل للمرأة (أحبّك) لن يذهب من قلبها أبداً).
إنّ الرجال المصطادين للنساء يستفيدون دائماً من هذا الإحساس عند المرأة ويجدون جملة (عزيزتي إنّني أموت في حبّك) أفضل شرك لاصطياد الفتيات اللواتي لم يدخلن في تجربة مع الرجال.
في هذه الأيام يتناقل الناس قصة امرأة اسمها (أفسر) حاولت الانتحار ورجل اسمه (جواد) حاول خداعها، وكان جواد يستخدم تلك الجملة من أجل الإيقاع بها. أمّا أفسر فتقول - حسب ما نقلته عنها مجلة (زن روز): (مع أنّني لم أكن أتحدث معه لكنّي كنت أُحب أن أراه كل يوم وكل ساعة).
(لم أكن قد عشقته ولكنّي كنت أشعر بحاجة نفسية إلى العشق الذي
أظهره. وهكذا كل النساء يجبن المعشوق قبل أن يجبن الحبّ نفسه. ويظهر الحب دائماً بالنسبة للفتيات والنساء بمجرّد وجود المحب؛ ولم أكن مستثناة من تلك القاعدة).
هذا ما حصل لامرأة ثيّب ذات تجربة، فما حال الفتيات الغريرات؟
من هنا ينبغي على الفتاة التي لم تختبر الرجال أن تشاور أباها وتحصل على موافقته؛ فهو أعرف بمشاعر الرجال ولا يريد لابنته إلاّ الخير والسعادة في معظم الحالات.
إنّ القانون هنا لم يحتقر المرأة أبداً، ولكنّه وضع على كتفها يد الحماية، وإذا سأل الفتيان لماذا لم يلزمنا القانون بالحصول على إذن الأب أو الأم؟ فليس بعيد عن المنطق أن يعترض أحد باسم الفتيات على وجوب الحصول على موافقة الأب.
إنّني أعجب من الأشخاص الذين يحثّون الفتيات على التمرّد ويوصونهن بعدم الاكتراث بأوليائهن، وهم يواجهون ويرون ويسمعون كل يوم قصصاً كقصص بيوك وزهرة وعادل ونسرين.
إنّ هذه الأعمال في رأيي نوع من التواطؤ بين أفراد يدّعون الحرص على مصلحة النساء، وهم يصنعون منهن فرائس سهلة لمصطادي النساء في العصر الحديث، ويهيّئون السهام ليسوقوا هذه الفرائس نحوهم.
* * *
في العدد 88 من مجلة (زن روز) يقول كاتب الأربعين اقتراحاً:
(إنّ المادة 1043 تخالف وتناقض جميع مواد القانون المتعلّقة بالبلوغ وسن الرشد، وتخالف أيضاً أساساً حرية الإنسان ومنشور الأمم المتحدة...).
يبدو أنّ الكاتب قد تصوّر أنّ مفاد المادة المذكورة هو أنّه يحق للآباء - ابتداءً - أن يزوّجوا بناتهم ممّن يشاؤون، أو أنّهم يحق لهم - بدون سبب - أن يمنعوا بناتهم من الزواج.
ترى أي ضير وأي منافاة مع حرية الإنسان تكمن في اشتراط موافقة الأب لصحّة الزواج مع إعطاء الفتيات حق الاختيار؟ وهذا أيضاً مشروط بأن لا يكون للأب سوء نيّة أو فساد ذوق يحول دون زواج ابنته. إنّ هذا الاشتراط إجراء احترازي وإشراف قانوني يهدف إلى صيانة المرأة التي ليست لها تجربة زوجية، وهو قائم على سوء الظن بطبيعة الرجال.
يقول الكاتب المذكور: (إنّ واضع القانون يعتبر الفتاة البالغة من العمر ثلاثة عشر عاماً صالحة للزواج قبل أن تبلغ مرحلة النضح الفكري وتفهم معنى الحياة الزوجية، وبهذا يسمح لمخلوق يصلح لشراء كمّيّة من الخضروات أن يختار لنفسه شريك حياته الذي يعيش معه طول عمره، في الوقت الذي لا يسمح لفتاة في الخامسة والعشرين أو الأربعين من عمرها وأتمّت تحصيلها الجامعي ووصلت إلى مستوى رفيع من الناحية
العلمية أن تختار زوجاً لها بدون إذن الأب أو الجد العامي الأمّي...).
أوّلاً: كيف يفهم من القانون السماح لفتاة في الثالثة عشرة من عمرها أن تختار زوجاً لها بدون إذن أبيها وعدم السماح لفتاة في الخامسة والعشرين أو الأربعين أن تفعل ذلك؟
ثانياً: إنّ اشتراط موافقة الأب محصورة في حدود العاطفة الأبوية وفهم مشاعر الرجل تجاه المرأة، أمّا إذا تحوّل ذلك الاشتراط إلى عائق فإنّه يسقط من الاعتبار.
ثالثاً: لا أظن أنّ قاضياً يدّعي أنّ القانون المدني لا يشترط النضج العقلي والفكري في الزواج، ويبيح لفتاة في سن الثالثة عشرة، والتي لا تفهم شيئاً عن الحياة الزوجية - كما يقول الكاتب - أن تتزوّج، إنّ المادة (211) من القانون المدني تقول:
(يعتبر المتعاملون واجدين للأهلية إذا كانوا عقلاء بالغين رشيدين) ومع أنّ هذه الجملة استعملت كلمة (متعاملون) وأنّ باب النكاح غير باب المعاملة، لكن السبب تبعية النكاح لعنوان أعمّ هو عنوان (العقود والمعاملات، والالتزامات) التي تبدأ من المادة (181) فإنّ خبراء القانون المدني يعتبرون المادة (211) معبّرة عن (الأهلية العامّة) اللازم توفّرها في سائر العقود.
إنّ جميع وثائق الزواج القديمة تترك فراغاً لاسم الرجل مسبوقاً بـ (البالغ العاقل الرشيد...)، وفراغاً آخر لاسم المرأة مسبوقاً بـ (البالغة
العاقلة الرشيدة...) فهل يعقل كون مدوّني القانون المدني غافلين عن هذه النقطة؟
إنّ مدوّني القانون المدني لم يكونوا يتصوّرون بأنّ الانحطاط الفكري سيصل إلى درجة يجب أن يقتضي الأمر تخصيص مادة جديدة في باب النكاح تشترط البلوغ والعقل والرشد مع وجود مادة عن الأهلية العامّة.
لقد تصوّر أحد شارحي القانون المدني (وهو الدكتور سيد علي شايگان) أنّ المادة (1064) التي تقول: (ينبغي أن يكون العاقد بالغاً وعاقلاً وقاصداً) متعلّقة بالزوجين وحيث إنّ هذه المادة لم تذكر الرشد إضافةً إلى البلوغ والعقل والقصد فقد تراءى له بأنّها تتناقض مع المادة (211) التي ذكرت الأهلية العامة، ثم حاول أن يبرّر هذا التناقض. بينما الحقيقة أنّ المادة (1064) تتحدّث عن العاقد لاعن الزوجين، ولا يشترط في العاقد أن يكون رشيداً.
إنّ الذي يستحق الاعتراض عليه في هذا المجال هو سلوك الإيرانيين، وليس القانون المدني ولا القانون الإسلامي. فغالبية الآباء يعطون لأنفسهم السلطة المطلقة على بناتهم كما كان الأمر في أيام الجاهلية، ويعتبرون تعبير البنت عن رأيها في اختيار زوجها وشريك حياتها وأبي أولادها في المستقبل لوناً من عدم الحياء وخروجاً عن اللياقة الأدبية، ولا يقيمون وزناً للنضج الفكري للفتاة، مع أنّ رأي الفتاة
في الزواج هو أمر ثابت في الإسلام.
وما أكثر عقود الزواج التي تقع قبل رشد الفتيات فتكون باطلة ولا يترتّب عليها أي أثر.
إنّ العاقدين لا يتثبّتون من رشد الفتيات ويعتبرون البلوغ وحده كافياً، بينما نعلم جميعاً كيف كان كبار العلماء يتثبّتون من النضج العقلي والفكري للفتيات قبل إجراء عقد قرانهم، كما تشير إلى ذلك الكثير من القصص. كما أنّ بعض العلماء كانوا يعتبرون النضج الديني للفتيات شرطاً فلا يعقدون قران البنت التي لا تستطيع أن تستدل فكرياً على أُصول الدين. ولكن الذي يؤسف له أنّ معظم أولياء الأطفال، والعاقدين يراعون ذلك.
لكن يبدو أنّ سوء تصرّف الناس ليس محلاًّ للانتقاد، بل المطلوب أن تكسر جميع الأقداح والقوارير برأس القانون المدني، وأن يعبّأ الرأي العام ضد هذا القانون المستخرج من الشريعة الإسلامية.
وفي رأيي أنّ الخلل الموجود في القانون المدني هو في المادة (1042) التي تقول: (بعد إكمال خمسة عشر عاماً من العمر أيضاً لا تستطيع الإناث بدون إذن أوليائهن أن يتزوّجن قبل إكمال ثمانية عشر عاماً من العمر).
فبموجب هذه المادة لا تستطيع المرأة الزواج بدون إذن وليّها إذا كان عمرها واقعاً بين 15 - 18 عاماً وإن كانت ثيّباً، وهو أمر لا يقرّه الفقه
الشيعي ولا المنطق العقلي؛ إذ لا ضرورة لموافقة الأب على زواج البنت الواجدة لشروط البلوغ والرشد إذا كانت قد تزوّجت من قبل.
* * *
الفصل الرابع
الإسلام وتجدّد الحياة (1)
مقتضيات العصر:
في مقدّمة كتاب (الإنسان والمصير) حيث بحثت مسألة عظمة وانحطاط المسلمين، قسّمت البحث حول أسباب انحطاط المسلمين إلى ثلاثة أقسام: الإسلام، المسلمون، العوامل الخارجية.
في هذه المقدمة، اعتبرت هذا الموضوع أحد المواضيع السبعة والعشرين الواجبة البحث والتحقيق، ووعدت بنشر رسالة تحت عنوان (الإسلام ومقتضيات العصر) أعددت لها ملاحظات كثيرة مسبقة.
في هذه السلسلة من المقالات لم أستطع أن أبحث جميع المواضع التي كان يجب أن تتضمّنها تلك الرسالة، لكنّني سأوضح إجمالاً ما يحل الإشكالات الواردة على أذهان قرّاء هذه المقالات المحترمين.
إنّ موضوع الدين والتقدّم من الموضوعات المطروحة أمام أتباع الأديان الأُخرى أكثر ممّا تُطرح أمام المسلمين. وكثير من مثقفي العالم العصريين إنّما تخلّوا عن الدين؛ لأنّهم تصوّروا أنّه لا ينسجم وتجدّد الحياة. تصوّروا أنّ التدين يستلزم التوقّف والجمود ومحاربة التقدّم والتطوّر. وبتعبير آخر قد فهموا خاصّية الدين على أنّها جمود
والبقاء على نفس الاشكال والصور بشكل دائم.
كان نهرو رئيس وزراء الهند الفقيد يحمل آراء علمانية، وكان لا يؤمن بأيّ دين أو مذهب، ويفهم من أقواله أنّ ما نفّره من الدين هو الجمود الديني. وكان في أواخر عمره يشعر بفراغ في وجوده وفي العالم اعتقد أنّه لا يملأ إلاّ بالطاقة المعنوية، لكنّه في نفس الوقت كان يستوحش من كل الأديان بسبب نظرته إلى الدين كشيءٍ ثابت النغمة.
وقد أجرى معه الصحفي الهندي (كارانجيا) مقابلة صحفية في أواخر عمره (طُبعت بالفارسية) يظهر أنّها كانت آخر تصريحاته حول المسائل العامة العالمية.
قال له كارانجيا فيما يتعلّق بغاندي: (إنّ بعض المثقفين يعتقدون أنّ غاندي بوسائله المعنوية وطرقه الروحية قد زلزل آراءك في الاشتراكية العلمية).
فأجاب نهرو قائلاً: (إنّ استثمار الأساليب المعنوية والروحية أمر لازم وجيد، وقد كنت أشارك غاندي هذه الآراء وأرى أنّ الإفادة من هذه الأساليب أكثر لزوماً هذه الأيام من أجل مواجهة الفراغ المعنوي للحضارة الحديثة التي تلقى رواجاً متزايداً).
وعاد كارانجيا يسأله عن الماركسية، فأجابه نهرو بذكر بعض نقائصها وطرح مجدّداً الأساليب الروحية كحلول لها. وعندها قال له كارانجيا:
(وأنت تتحدّث الآن عن المناهج الأخلاقية والروحية كحلول للمشكلات ألا ترى أنّك تختلف عن جواهر لال نهرو الذي عرفناه بالأمس؟ (أي نهرو في سن الشباب)، فإنّ الذي تقوله الآن يظهر لنا أنّ السيد نهرو في أواخر عمره قد أخذ يبحث عن الله).
فقال نهرو: (نعم، لقد تغيّرت، وإنّ تأكيدي على الموازين الأخلاقية والروحية ليس أمراً عفوياً...) وأضاف: (والمطروح الآن هو كيف يمكن أن نسمو بالأخلاق والروحيات إلى مستوى أعلى) ويجيب هو نفسه قائلاً:
(بديهي أنّ هناك الدين، لكن للأسف فإنّ الدين قد هبط مستواه نتيجة لوجود النظرة الضيّقة، والتقيّد بقوانين جافّة وجامدة، والاقتصار على بعض الشكليات، وقد ذهب مفهومه الحقيقي وروحه ولم يبق إلاّ القشور).
الإسلام ومقتضيات العصر:
من بين جميع الأديان والمذاهب لا يوجد مذهب أو دين تدخّل في الشؤون الحياتية للناس كما تدخّل الإسلام، إنّ الإسلام لم يكتف في مقرّراته بمجموعة من العبادات والأذكار والأوراد ومجموعة أخلاقيات وإنّما قام بالإضافة إلى بيان علاقات العباد بربّهم. بتوضيح الخطوط الرئيسة للعلاقات الإنسانية وحقوق وواجبات الإفراد تجاه بعضهم البعض؛ لذا فإنّ مسألة الانسجام مع العصر فيما يتعلّق بالإسلام
بمواصفاته هذه، مسألة واردة.
وممّا يلفت النظر أنّ الكثير من العلماء والكتّاب الأجانب، قد درسوا الإسلام من حيث قوانينه الاجتماعية والمدنية وأقرّوا أنّ القوانين الإسلامية مجموعة من القوانين الراقية، وأشادوا بميزة هذا الدين لحيويته وقابلية قوانينه للانسجام مع التقدّم العصري.
قال برنارد شو الكاتب الانگليزي المتحرّر المعروف: (لقد كنت دائماً أكن غاية الاحترام لدين محمد بسبب حيويته العجيبة، وفي رأيي أنّ الإسلام هو الدين الوحيد الذي يملك الاستعداد للتلاؤم ولتوجيه الحالات المتنوّعة والصور الحياتية المتغيّرة ولمواجهة العصور المختلفة، وإنّني لأتنبأ - وإنّ علامات هذه النبوءة قد ظهرت منذ الآن - أنّ دين محمد سيكون محل قبول أوروبا غداً).
(إنّ رجال الدين في القرون الوسطى - نتيجة للجهل أو التعصّب - قد رسموا لدين محمد صورة قاتمة، فقد كانوا يعتبرونه عدوّاً للمسيحية لكنّني قد اطلعت على أمر هذا الرجل فوجدته أعجوبة خارقة، وتوصّلت إلى أنّه لم يكن عدوّاً للمسيحية بل إنّه يجب أن يسمّى منقذ البشرية. وفي رأيي أنّه لو تولّى أمر العالم اليوم لوفق في حلّ مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرنوا البشر إليها).
والدكتور شبلي شميل العربي اللبناني، المادي المذهب، قام بترجمة كتاب أصل الأنواع لداروين إلى اللغة العربية لأوّل مرّة مع شرح
(بوخنر) الألماني وجعله في متناول أيدي الناطقين باللغة العربية، وبقصد محاربة العقائد المذهبية.
إنّه بالرغم من ماديته إلاّ أنّه لا يخفي إعجابه بالإسلام وما بناه من عظمة، وكان على الدوام يُعدّ الإسلام مبدأً قابلاً للتطبيق في كل زمان.
هذا الرجل كتب مقالة تحت عنوان (القرآن والعمران) في الجزء الثاني من كتابه فلسفة النشوء والارتقاء والصادر باللغة العربية. هذه المقالة هي ردّ على أحد الأجانب الذين زاروا البلاد الإسلامية وعدّ الإسلام مسؤولاً عن تأخّر المسلمين. يسعى شبلي شميل من خلال هذه المقالة إلى إثبات أنّ سبب تأخّر المسلمين وهو الانحراف عن تعاليم الإسلام الاجتماعية لا الإسلام، وأنّ أولئك الغربيين الذين يهاجمون الإسلام إمّا أنّهم لا يعرفونه، أو أنّهم سيّئو النيّة يريدون أن يشوّهوا صورة القوانين والمقرّرات الإسلامية في أنظار الشرقيّين ويضعوا طوق العبودية في أعناقهم.
وفي عصرنا أصبح التساؤل حول ما إذا كان الإسلام ينسجم مع العصر أو لا أمراً عامّاً. وحين اتصلت بمختلف طبقات المجتمع وخصوصاً الطبقة المثقّفة والمطّلعة لم أجد موضوعاً يسألون عنه أكثر من هذا الموضوع بالذات.
إشكالات:
بعض الأحيان، يحاول هؤلاء تغليف أسئلتهم بغلاف فلسفي
فيقولون: كل شيءٍ متغيّر في العالم ولا يوجد شيء ثابت أبداً، والمجتمع البشري ليس استثناءً لهذه القاعدة فكيف يمكن لمجموعة من القوانين الاجتماعية أن تبقى ثابتة على الدوام؟
ولو أردنا أن نجيب على هذا السؤال جواباً فلسفياً بحتاً؛ لكانت الإجابة واضحة جداً. إنّ الأشياء المتغيّرة التي تكون جديدة وقديمة، في نمو وضمور، في رقي وتكامل، هي المواد المركبات المادية في الوجود. أمّا قوانين الوجود فثابتة، فمثلاً: إنّ الموجودات الحيّة تكاملت وتتكامل طبق قوانين خاصة وقد بيّن العلماء قوانين التكامل هذه. فالموجودات الحيّة نفسها دائمة التغيّر والتكامل لكن ما بال قوانين التغيّر والتكامل؟ بالطبع هي لا تتغيّر ولا تتكامل وحديثنا الآن حول هذه القوانين، وهنا لا فرق بين القانون الطبيعي أو الوضعي؛ إذ من الممكن أن يكون القانون الوضعي مستنداً إلى الفطرة والطبيعة، ومعيناً لخط السير التكاملي للأفراد والجماعات.
لكن التساؤل حول انسجام الإسلام أو عدم انسجامه مع مقتضيات العصر ليس ذا جانب فلسفي وعام وحسب، فإنّ السؤال الذي يطرح أكثر من غيره هو أنّ القوانين إنّما توضع على ضوء الاحتياجات، وأنّ احتياجات الإنسان الاجتماعية ليست ثابتة، إذاً فلا يمكن أن تكون القوانين الاجتماعية ثابتة.
هذا السؤال جيّد وذو قيمة؛ إذ إنّ من معجزات الدين الإسلامي
المبين التي يفتخر بها كل مسلم واعٍ وعالم هي أنّ الإسلام وضع للاحتياجات الثابتة للفرد والمجتمع قوانين ثابتة، وللحاجات المؤقّتة والمتغيّرة مقرّرات مرنة. وهذا ما سنبيّنه إن شاء الله بمقدار ما ينسجم وهذه المجموعة من المقالات.
مع أيّ شيءٍ ينسجم العصر نفسه؟
قبل البدء بهذا البحث يجب أن أوضح أمرين:
الأوّل: إن أكثر الذين ينادون بالتقدّم والتكامل وتغيير الأوضاع العصرية يتصوّرون أنّ كل تغيّر في الأوضاع الاجتماعية، خصوصاً ذلك الذي يصدره الغرب، لابد أن يُعدّ تكاملاً وتقدّماً، وهذا من أكثر الأفكار التي سادت بين الناس هذه الأيام ضلالاً.
يخيّل لهذه المجموعة أنّ وسائل المعيشة والرفاه إذ تتغيّر يوماً بعد بوم، ويحل الكامل محل الناقص، وإذ يكون العلم والصناعة في حالة تقدّم مستمر، فمن الواجب علينا أن نرحّب بأيّ تغيير يطرأ على حياة الإنسان وأن نعدّه نوعاً من الرقي والتقدّم، إنّها الحتمية التاريخية، ولابد أن تأخذ طريقها رضينا أم أبينا.
هذا في الوقت الذي لا تكون جميع التغييرات نتيجة مباشرة للعلم والصناعة ولا وجود للحتم أبداً؛ ففي الوقت الذي يكون العلم في تقدّم، لا تقف الطبيعة المتمرّدة للبشر مكتوفة اليدين. العلم والعقل يدفعان بالإنسان نحو الكمال، والطبيعة الإنسانية المتمرّدة تجرّه نحو الفساد
والانحراف؛ إذ إنّ شهوات الإنسان الطبيعية تسعى لأن تجعل من العلم أداةً بيدها لخدمة الشهوة والرغبات الحيوانية. فالعصر في القوت الذي يستوعب التقدّم والتكامل يستوعب الفساد والانحراف أيضاً؛ لذا يجب أن نتقدّم مع تقدّم العصر ونكافح فساده وانحرافه. إنّ المصلح والرجعي كليهما ثائران على العصر، مع فارق أنّ المصلح ثائر ضدّ الانحراف والرجعي تائر ضد التقدّم. فإذا اتخذنا العصر وتغيّراته فأين إذاً دورهم الفعّال والخلاق والبناء؟
إنّ الإنسان الذي امتطى مركّب العصر وهو في حركة مستمرّة يجب أن لا يغفل لحظة عن قيادة هذا المركّب. أمّا الذين يتحدثون عن تغييرات العصر بينما هم غافلون عن قيادته، فقد نسوا دور الإنسان الفعّال في ذلك، وهم كالفارس الذي أسلس قياده لفرسه.
والأمر الثاني: انسجام أم إلغاء؟ الذي يجب أن أشير إليه هنا هو أنّ بعض الأفراد قد حلّوا مشكلة (الإسلام ومقتضيات العصر) بطريقة بسيطة وسهلة. فهم يقولون إنّ الإسلام دين خالد يتواءم مع كل عصر وزمان. فإذا سألناهم كيف يتم هذا التواؤم؟ ما طريقته؟ قالوا: إذا رأينا الزمان قد تغيّر ألغينا - فوراً - القوانين الأُولى ووضعنا بدلها قوانين
جديدة!! إنّ كاتب الأربعين مقترحاً قد حلّ المشكلة على هذه الصورة. إنّه يقول إنّ القوانين الدنيوية التي جاءت بها الأديان لابد أن تكون مرنة تنسجم وتتواءم مع التقدّم العلمي والتطوّر الحضاري فإنّ هذه المرونة والقابلية على التواؤم مع مقتضيات الزمان ليست غير مخالفة لتعاليم الإسلام الرفيعة فحسب، بل إنّها تتطابق وروحيته (مجلة (زن روز) أي (امرأة اليوم) العدد 90 صفحة 70).
يقول الكاتب المذكور قبل وبعد الجمل السابقة: (ما دامت مقتضيات الزمان في تغيّر، وكل زمان يستوجب سنّ قوانين جديدة، وكانت قوانين الإسلام المدنية والاجتماعية تتناسب مع الحياة البسيطة لعرب الجاهلية، بل كانت غالباً مماثلة لعادات الجاهلية ولا تنسجم والعصر الحاضر، فيجب أن نضع بدلها اليوم قوانين جديدة).
إنّنا يجب أن نسأل مثل هؤلاء (إذا كان معنى القابلية على التواؤم مع العصر هو القابلية على الإلغاء، فأيّ قانون لا يملك مثل هذه المرونة؟ وأيّ قانون لا ينسجم بهذا المعنى مع العصر والزمان؟).
إنّ هذا التعليل لمرونة وقابلية الإسلام على الانسجام مع الزمان يشبه قول شخص (إنّ الكتاب والمكتبة أحسن وسيلة للتلذّذ في الحياة) وحين نسأله عن توضيح ذلك يجيب؟ (لأنّ الإنسان متى أراد أن يلهو عرض الكتب بأسعار مخفضةٍ للبيع وأنفق ثمنها في الأُنس والطرب).
يقول الكتاب المذكور (إنّ تعاليم الإسلام ثلاثة أنواع):
النوع الأول: أصول العقائد، كالتوحيد والنبوّة والمعاد وغيرها.
النوع الثاني: العبادات، من قبيل: المقدّمات والمقارنات كالصلاة والصوم والوضوء والطهارة والحج وغير ذلك.
النوع الثالث: القوانين المتعلّقة بحياة البشر.
النوعان الأول والثاني جزء من الدين، وهما يمثّلان الشيء الذي يجب أن يحتفظ به الناس دائماً، أمّا النوع الثالث فليس جزءاً من الدين؛ إذ إنّ الدين لا يتدخل في حياة الناس، كما أنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) لم يطرح هذه القوانين على أنّها جزء من الدين والرسالة، ولكن بما أنّه (صلّى الله عليه وآله) كان حاكماً، فقد مارس عمليا هذه الأمور، وإلاّ فدور الدين ينحصر فقط في دعوة الناس إلى الصلاة والصوم ولا شأن له بحياة الناس).
إنّني لا استطيع أن أتصوّر أنّ شخصاً يعيش في بلد إسلامي يمكن أن يكون جاهلاً بمنطق الإسلام إلى هذا الحد.
ألم يبيّن القرآن هدف الأنبياء والمرسلين؟ ألم يقل بصراحة:( لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ ) .
إنّ القرآن يذكر العدالة الاجتماعية على أنّها الهدف الأساس لجميع الأنبياء.
إذا أردتم ألاّ تعملوا بالقرآن فلم ترتكبون إثماً كبيراً وتلصقون التهم بالإسلام والقرآن؟ إنّ أكثر التعاسات التي ابتلي بها البشر اليوم تنبع من
إعراضهم عن الدين الذي يمثّل السند الوحيد للأخلاق والقانون.
إنّنا نسمع منذ ما يقرب من نصف قرن نغمةً مفادها أنّ الإسلام جيّد لكن بشرط أن يبقى في حدود المساجد ولا ينزل إلى المجتمع. هذه النغمة قد جاءت من وراء الحدود الإسلامية، ودعي إليها في جميع البلاد الإسلامية.
ولأوضّح هذه الجملة بلغة أسهل؛ كي يتبيّن الهدف الأساس لدعاتها:
إنّ خلاصة الفكرة هي: (إنّ الإسلام في الحدود التي يقف فيها بوجه الشيوعية يجب أن يبقى، أمّا حين يمس المصالح الغربية فيجب أن يزول). المقررات الإسلامية العبادية يجب أن تبقى - من وجهة نظر الشعوب الغربية - لكي يمكن عند اللزوم استخدامها لتحريض الناس ضد الشيوعية بعنوان أنّها نظام إلحادي. أمّا تعاليم الإسلام الاجتماعية والتي تمثّل فلسفة حياة الشعوب المسلمة والتي باتباع المسلمين لها والتزامهم بها يعظم شعورهم بالاستقلال والشخصية المتميّزة في مقابل شعوب الغرب، والتي تمنع الغرب الجشع من احتوائهم واستغلالهم إلى أقصى حدٍّ ممكن، وتذويب شخصيتهم، هذه التعاليم يجب أن تمحى من الوجود.
والمؤسف أنّ مبتدعي هذه الأطروحة قد وقعوا في خطأٍ جسيم:
أوّلاً: لأنّ القرآن منذ أربعة عشر قرناً قد قضى على مفهوم (نؤمن ببعض ونكفر ببعض) وأعلن أنّ مفاهيم الإسلام وتعاليمه لا تتجزّأ.
ثانياً: اعتقد أنّ الوقت قد حان لئلاّ يخدع المسلمون بمثل هذه الأساليب الحاسّة الناقدة قد نمت عند الشعوب إلى حدٍّ ما، وصارت تميّز بين مظاهر التقدّم والرقي الناتجة عن تحرّر الطاقات العلمية والفكرية للإنسان وبين مظاهر الفساد والانحراف حتى لو كانت آتية من الغرب.
إنّ شعوب البلاد الإسلامية قد أخذت تدرك - أكثر من ذي قبل - قيمة التعاليم الإسلامية، وتفهم أنّ أساس استقلال حياتها هو الإسلام والتعاليم الإسلامية ولن تتخلّى عنها بأيّ ثمن.
إنّ الشعوب الإسلامية أدركت أنّ الدعايات التي تطلق حول القوانين الإسلامية ليست في حقيقتها إلاّ خدعة استعمارية.
ثالثاً: يجب أن يعلم مبتدعو هذه الأطروحة أنّ الإسلام قادر على أن يقف بوجه أيّ نظام، إلحادياً كان أو غير إلحادي، بشكل فلسفة حياتية تحكم المجتمع ولا تنزوي في المساجد، فالإسلام الذي يحبسونه في المساجد، في الوقت الذي يخلي الساحة لسيطرة الأفكار الغربية، كذلك سيخليها لسيطرة الأفكار ضد الغربية والثمن الباهظ الذي يدفعه الغرب اليوم في بعض البلاد الإسلامية هو ثمرة هذا الخطأ.
* * *
(2) الإسلام وتجدّد الحياة
ليس الإنسان هو الكائن الحي الوحيد الذي يحيا حياة اجتماعية، فكثير من الحيوانات وخاصة الحشرات تحيا حياة اجتماعية أيضاً، وتتبع مجموعة من المقرّرات والأنظمة الحكيمة، ويحكمها التعاون وتوزيع الأعمال، والإنتاج والتوزيع والأمر والطاعة.
فللنحل وبعض أنواع النمل والأرضة(1) حضارات وأنظمة وتشكيلات لن يبلغها الإنسان إلاّ بعد سنوات بل قرون وهو أشرف المخلوقات.
وحضارة هذه الحيوانات عكس حضارة الإنسان فهي لم تمر بمراحل من قبيل عصر الغابة والعصر الحجري وعصر الحديد والصلب، وعصر الذرّة. بل إنّها منذ أن وضعت أقدامها في هذه الدنيا كانت لديها نفس هذه الحضارات والتشكيلات التي لها اليوم ولم يتغيّر حالها أبداً. أمّا الإنسان فطبقاً للآية الكريمة:( وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفاً ) بدأت حياته من الصفر وستستمر إلى ما لانهاية.
____________________
(1) الأرَضَة بالتحريك: دودة بيضاء شبه النملة تظهر في أيام الربيع فمنها صغار وهي آفة الخشب خاصة، ومنها كبار مثل كبار النمل ذوات أجنحة وهي آفة كل شيء من خشب ونبات، غير أنّها لا تعرض للرطِب. (لسان العرب، ج7، باب المعجمة، فصل الألف).
ومقتضيات العصر بالنسبة للحيوانات واحدة على الدوام لا تتغيّر. وليس لحب التجدّد وعبادة الجديد معنى لديها، ولا يوجد عندها عالم جديد وآخر قديم والعلم يكتشف لها كل يوم اكتشافاً جديداً يغيّر أوضاعها، والمصنوعات الخفيفة والثقيلة لا تردّ أسواقها كل يوم بأشكال أحدث وأكمل. لماذا؟ لأنّها تحيا بالغريزة لا بالعقل.
أمّا الإنسان فحياته الاجتماعية دائماً عرضة للتغيّر والتحوّل. ففي كل قرن تتغيّر حياته، وسرّ كون الإنسان أشرف المخلوقات يكمن في أنّه ابن الطبيعة البالغ الرشيد. وقد بلغ مرحلة استغنى فيها عن قيمومة الطبيعة ورعايتها المباشرة له باسم الغريزة. إنّه يحيا بالعقل وليس بالغريزة.
إنّ الطبيعة قد اعترفت ببلوغ الإنسان وتركته حرّاً ورفعت عنه وصايتها. وإنّ ما ينجزه الحيوان بالغريزة والقانون الطبيعي الذي لا يقبل التمرّد، ينجزه الإنسان بوساطة القوى العقلية والعلمية والقوانين الوضعية والتشريعية القابلة للتمرّد؛ وهنا يكمن سر الفساد والانحراف الذي يطرأ على مسيرة التقدّم والتكامل الإنسانية وسرّ التوقّف والانحطاط، وسرّ السقوط والهلاك.
وكما أنّ طريق التقدّم والرقي مفتوح أمام الإنسان، كذلك فإنّ طريق الفساد والانحراف والسقوط ليس موصداً بوجهه.
إنّ الإنسان قد بلغ المرحلة التي سمّاها القرآن الكريم مرحلة حمل
الأمانة التي أشفقت من حملها السماوات والأرض والجبال. أي إنّه قبل الحياة الحرّة ومسؤولية التكليف والقانون، وهو لهذا السبب ليس مصوناً من الظلم والجهل ومن الخطأ وعبادة الذات.
والقرآن الكريم بعد أن يبيّن الاستعداد العجيب للإنسان في تحمّل أمانة التكليف يصفه مباشرةً بصفتي: (الظلوم) و(الجهول).
إنّ هذين الاستعدادين لدى الإنسان (استعداد التكامل واستعداد الانحراف) ينفكّان عن بعضهما. فالإنسان ليس كالحيوان الذي لا يتقدّم في حياته الاجتماعية ولا يتأخّر ولا يذهب يميناً ولا شمالاً، ففي حياة الناس تقدّم وتأخّر، وإذا كانت في حياتهم حركة وسرعة ففيها كذلك توقّف وانحطاط، وإذا كان فيها تقدّم وتكامل، ففيها أيضاً فساد وانحراف، وإذا كان هناك عدل وخير كذلك يوجد ظلم واعتداء، وإذا كانت هناك مظاهر للعلم والعقل فكذلك توجد مظاهر للجهل والعبث.
والتغييرات والظواهر التي تستجد في كل عصر يمكن أن تكون من النوع الثاني.
الجامدون والجاهلون
الإفراط والتفريط من جملة خواص الإنسان، فهو إذا أراد أن يقف عند حد الاعتدال؛ وجب عليه أن يسعى لفصل التغييرات التي هي من النوع الأول عن التغييرات التي هي من النوع الثاني... أن يسعى لتطوير العصر بقوّة العلم والابتكار والسعي والعمل... أن يسعى للانسجام مع
مظاهر الرقي والتقدّم في عصره، ويسعى أيضاً للحيلولة دون وقوع الانحرافات العصرية واجتناب الاصطباغ بصبغتها.
لكن للأسف ليس الأمر دائماً كذلك، فهناك مرضان خطيران يهدّدان الإنسان في هذا المجال هما مرض الجمود ومرض الجهل. عاقبة المرض الأوّل التوقّف والسكون والتخلّف، وعاقبة المرض الثاني السقوط والانحراف.
فالجامد ينفر من كل جديد ولا يأنس إلاّ بالقديم، والجاهل يبرّر كل جديد باسم مقتضيات العصر وباسم التجدد والرقي، والجامد يعد كل جديد فساداً وانحرافاً، والجاهل يحسب كل شيء على الحضارة والتقدم العلمي.
الجامد لا يفرق بين البذرة والقشرة، ولا بين الوسيلة والهدف، فالدين في نظره ملزم بحفظ الآثار القديمة، والقرآن في نظره إنّما نزل من أجل أن يوقف حركة التاريخ ويثبت أوضاع العالم في أوضاعها التي هي عليها.
وفي نظره أنّه قراءة جزء عمّ، والكتابة بالقصبة، واستعمال محفظة قلم من الورق المقوى، والغسل في حوض الحمام القديم، وتناول الطعام باليد، واستعمال مصباح نفطي والعيش في الجهل والأميّة... هي شعائر دينية المحافظة عليها. والجاهل على عكس ذلك، أنظاره مشدودة إلى العالم الغربي يرقب أي موضة جديدة ظهرت وأي عادة
بدأت ليقوم فوراً بتقليدها وإطلاق اسم الحتمية التاريخية عليها.
إنّ الجامد والجاهل كليهما يفترضان أنّ كل وضع قديم هو جزء من الشعائر الدينية، مع فارق أنّ الجامد يرى أنّ هذه الشعائر يجب حفظها، والجاهل يرى أنّ الدين أساس يقترن بعبادة القديم وحب السكون والثبات.
في القرون الأخيرة، كانت مسألة تعارض العلم والدين محل الجدل وأخذ ورد كبيرين بين شعوب الغرب. وفكرة تعارض الدين والعلم لها جذران.
الأول: أنّ الكنيسة كانت قد تبنت مجموعة من المسائل العلمية والفلسفية القديمة على أنّها قضايا دينية يجب الاعتقاد بها، ثم أثبت تقدّم العلوم خلافها.
الثاني: كون العلم قد غير وجه الحياة وطرق العيش.
إنّ المتديّنين الجامدين بنفس الطريقة التي أضفوا بها على بعض المسائل الفلسفية لوناً دينياً، حاولوا أن ينسبوا إلى الدين الشكل المادي الظاهر للحياة فتصوّر الجاهل أنّ المسألة هكذا في الواقع وأنّ الدين قد تبنّى صورة مادية لحياة الناس، ولما كان الشكل المادي للحياة - بفتوى العلم - يجب أن يتغيّر، إذا اصدر العلم فتوى إلغاء الدين.
وعى هذا فالجمود بالدرجة الأُولى والجهل بالدرجة الثانية جاءا بخرافة تعارض العلم والدين.
أمثال القرآن: الإسلام دين متطوّر ومطوّر، والقرآن الكريم - من أجل أن يوجّه أنظار المسلمين إلى أن يكونوا دائماً في حالة نمو وتكامل على ضوء الإسلام - يورد مثلاً واصفاً المجتمع المسلم فيقول:( كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزّرّاعَ ) (1) .
هذا مثل للمجتمع الذي يريده القرآن، ونموذج لما يأمله القرآن، إنّه يخطّط للمجتمع ليكون دائماً في حالة نمو وتوسّع وانبساط.
يقول (ويل ديورانت): (لم يدع دين أتباعه إلى القوّة كما دعا الإسلام، وتاريخ صدر الإسلام يريك إلى أي مدى استطاع الإسلام أن يبني المجتمع من جديد ويدفعه إلى أمام).
إنّ الإسلام يعارض الجمود كما يعارض الجهل، والخطر الذي يهدّد الإسلام آت إمّا من هذه الفقرة أو تلك. فالجمود وتحجّر الأدمغة والتمسّك بكل قديم إضافة إلى أنّها لا تمتّ إلى الإسلام بصلة، فهي تعطي المبرّر للجهلة من الناس ليتصوّروا أنّ الإسلام يعارض التجدّد بمعناه الحقيقي، ومن ناحية أُخرى فإنّ التقليد وعبادة الموضة والتأثّر بالغرب والاعتقاد بأن سعادة شعوب الشرق تكمن في أن يصبحوا أفرنجة جسماً وروحاً وباطناً وظاهراً وأن يقبلوا جميع عاداتهم وآدابهم وسننهم، وينسّقوا قوانينهم المدنية والاجتماعية بطريقة عمياء طبق قوانين
____________________
(1) سورة الفتح، الآية 29.
الغربيين، كل هذا يمنح الجادين المبرّر لأن ينظروا بعين الريبة إلى كل جديد ويعدونه خطراً على دين واستقلال وشخصية شعوبهم الاجتماعية.
وبين هذا وذلك فإن الإسلام هو الذي يجب أن يدفع ثمن خطأ الفريقين.
فجمود الجامدين يمنح الجاهلين مجالاً للهجوم، وجهل الجاهلين يزيد الجامدين إصراراً على البقاء على عقائدهم الجامدة.
العجيب أنّ هؤلاء الجهّال المتظاهرين بالتحضر يظنون الزمان (معصوماً) وهل تغيّرات الزمان والعصر الإنتاج جهود الإنسان؟ فمنذ متى أصبح البشر معصومين عن الخطأ لكي تكون تغيرات العصر معصومة هي الأُخرى؟
إنّ الإنسان كما يتأثّر بالميول العلمية والأخلاقية والذوقية والدينية ويقوم في كل عصر بابتكار ما يصلح حال البشرية، كذلك يتأثّر بميول عبادة الذات وطلب الجاه، والعبث الجنسي وحب المال والاستغلال. والإنسان كما يوفق أحياناً إلى اكتشافات جديدة ويعثر على طرق وأساليب علمية جديدة كذلك يقع أحياناً أُخرى ضحّيّة الخطأ والاشتباه لكن الجاهل لا يفهم هذا الكلام إنّما محور كلامه أنّ العالم اليوم كذا وكذا.
والأعجب من هذا أنّهم يقيسون مبادئ حياتهم على الحذاء والقبعة والملابس. فكما أنّ من الحذاء والقبعة جديداً وقديماً وكما أنّه
حين يكون جديداً يكون ذا قيمة فيشترى ويحتذى فإذا قدم رمي بعيداً، فحقائق العالم إذاً من هذا القبيل، ليسل للجيّد والرديء - في نظر هؤلاء الجاهلين - مفهوم غير مفهوم الجديد والقديم، فالاقطاعي في نظرهم - وهو الذي نصب نفسه مالكاً ظلما، وجلس لتقوم بالعمل مئات الأيدي والسواعد من أجله - سيّئ لأنّه صار قديماً يرفضه العالم اليوم، مرحلته انتهت، وقدمت موظته. أمّا في اليوم الذي وجد فيه وخرج حديثاً من القالب، وعرض في أسواق العالم فقد كان جيّداً.
في نظر هؤلاء استغلال المرأة سيء؛ لأنّ عالم اليوم لم يعد يعجبه ذلك ولا يرضى به. أمّا في الأمس حيث لم يكونوا يورثون المرأة، ولا يعترفون لها بحق التملّك ولا يحترمون إرادتها ورأيها فقد كان ذلك جيّداً؛ لأنّه كان جديداً في وقته.
يعتقد هؤلاء الأفراد، أنّ العصر بما أنّه عصر الفضاء فلا يمكن أن نترك الطائرة ونركب الحمار، ونترك الكهرباء ونوقد المصباح النفطي، ونترك معامل النسيج الضخمة وننسج باليد، نترك مكائن الطباعة العملاقة ونكتب باليد، وكذلك لا يمكن أن نترك المشاركة في حلقات الرقص، ولا نترك الذهاب إلى حفلات العري (إلاّ من المايو) أو حفلات الطعام الباذخة ولا نترك السكّر والعربدة، ولا نترك لعب القمار ولا نترك موضة الملابس القصيرة فكل هذه من ظواهر القرن. وإن لم نفعل فقد رجعنا إلى عصر ركوب الحمير. كم أدّت كلمة (ظاهرة القرن) إلى تحطيم
أفراد، وكم قضت على عوائل تفوق الحصر.
يقولون: عصر العلم، وقرن الذرّة، وزمن الأقمار الصناعية، ومرحلة الصواريخ عابرة القارات. حسناً، ونحن نشكر الله على أنّنا نعيش في هذا العصر والزمان وفي هذا القرن والعهد، ونأمل أن نفيد أكثر فأكثر من مزايا العلوم والصناعات. ولكن هل نضبت العيون في هذا العصر إلاّ عين العلم؟ وهل جميع ظواهر هذا القرن هي من نتائج التقدّم العلمي؟ وهل يدعي العلم أنّ الطبيعة تجعل من شخص العالم شخصاً هادئاً ومطيعاً وإنسانياً مئة في المئة.
إنّ العلم لا يدعي مثل ذلك بالنسبة لشخص العالم؛ إذ تجد أنّ مجموعة من العلماء ينهمكون في البحث العلمي بكل صفاء وصدق نية وتأتي مجموعات من طالبي الجاه وأصحاب الهوى وعباد المال ليستخدموا نتائج جهودهم من أجل نيل مقاصدهم الدنيئة، وأنّ العلم ليئنّ بسبب استغلاله في غير وجوهه الإنسانية لإرضاء الطبيعة المتمرّدة للإنسان، وما منشأ تعاسة هذا القرن ومصائبه إلاّ من ذلك.
علم الفيزياء يتقدّم ويكتشف قوانين الضوء فتأتي مجموعة من النفعيين ليستخدموا ذلك في إنتاج الأفلام التي تهدم الأُسرة. وعلم الكيمياء يتطوّر ليكتشف خواص العناصر المختلفة فيأتي بعض الأفراد ليستخدموا هذه الإمكانية في تهيئة ما يقتل روح الإنسان كالهيروئين. وينفذ العلم إلى باطن الذرّة ويطلق طاقتها العجيبة، لكن قبل أن تستخدم
أدنى استخدام لصالح الإنسانية يهرع طلاّب الجاه والشهرة ليصنعوا منها القنبلة الذرّيّة العجيبة ويلقوها فوق رؤوس الأبرياء. حين أقاموا لـ (اينشتاين) عالم القرن العشرين العظيم احتفالاً تكريميّاً، قام هو ووقف خلف المنصّة وقال: إنّكم تحتفلون بعالم كان سبباً في صناعة القنبلة الذرّية؟!
إنّ اينشتاين لم يستخدم طاقته العلمية من أجل أن تصنع القنبلة الذرّيّة، إنّما طلاّب الجاه هم الذين استخدموا علمه في هذا المجال.
إنّ الهيروئين والقنبلة الذرّيّة والأفلام المختلفة لا يمكن تبريرها بأنّها (ظاهرة القرن). فلو أنّ أقوى القنابل صبّت على رؤوس الأبرياء بواسطة أحدث أنواع القاذفات نتيجة لأحسن جهود العلماء، فلن يقلّل ذلك من وحشيّة هذا العمل مقدار ذرّة.
(3) الإسلام وتجدّد الحياة
إنّ كل ما يتذرّع به الداعون إلى اتباع النظم الغربية في الحقوق الأُسرية هو أنّ وضع العصر قد تغيّر، وأنّ مقتضيات القرن العشرين تتطلّب ذلك، فإذا لم نوضح نظرتنا في هذا الباب، فسيكون بحثنا ناقصاً. لكن لو أردنا أن نشبعه بحثاً وتحقيقاً فلن تستوعبه هذه المجموعة من المقالات؛ إذ إنّ هناك مسائل كثيرة يجب أن تُطرح وتبحث؛ بعضها فلسفي وبعضها فقهي وبعضها الآخر أخلاقي واجتماعي. وآمل أن يتم ذلك في الرسالة التي أزمع إعدادها تحت عنوان: (الإسلام ومقتضيات
العصر) والتي أعددت أوراقها الأساسية. أمّا الآن فأكتفي بتوضيح أمرين:
الأوّل: التواؤم مع تغييرات العصر
إن التواؤم مع تغيّرات العصر ليس بالبساطة التي يتصوّرها الأدعياء الجهّال ويكثرون فيه الحديث. فإنّ في العصر تقدّماً كما أنّ فيه انحرافاً، فيجب المضي قدماً مع تقدّم العصر، ومحاربة الانحراف فيه. ومن أجل تشخيص هاتين المسألتين وفصلهما عن بعضهما، يجب أن ينظر إلى الظواهر والحوادث العصرية من أين تنبع وإلى أين تجري؟ كما يجب أن يحدّد من أي طبع في الوجود الإنساني، ومن أي طبقة من طبقات المجتمع تصدر؟ أمن الطباع والرغبات الخيّرة والإنسانية في الإنسان، أم من ميوله الحيوانية والدنيئة؟ أهي صادرة من العلماء وبحوثهم النزيهة أم عن العبث وطلب الجاه وعبادة المال لدى الطبقات الفاسدة في المجتمع؟ وهذا الأمر قد وُضّح في المقالتين السابقتين.
الثاني: سرّ المرونة في القوانين الإسلامية
أمّا الأمر الثاني الذي يجب توضيحه فهو أنّ المفكّرين الإسلاميين يعتقدون أنّ في الإسلام سرّاً ورمزاً يمنحان هذا الدين القابلية عن التكيف مع تطورات العصر. ويعتقدون أنّ هذا الدين يتماشى مع التقدّم العصري والتطوّر الثقافي والتغيّرات الناتجة عنهما. ولنعرف الآن ما هو هذا السر؟ وبتعبيرٍ آخر ما هذه الروابط والفواصل التي تخلّلت بناء هذا
الدين ومكّنته من التكيّف مع الأوضاع المتغيّرة الناشئة عن تطوّر العلم والثقافة دون أن يصطدم بها، أو أن يتخلّى عن أحد قوانينه من أجل الانسجام معها؟ هذا هو ما سنوضحه في هذه المقالة.
لقد فطن بعض القرّاء وفطنت أنا إلى أنّ هذه المسألة لها جانب فنّي وتخصّصي ويجب ألاّ تُطرح إلاّ على أهل الاختصاص.
ولكن نظراً لأنّ بين السائلين والمهتمّين بهذه المسألة كثيراً من المتشائمين الذين يصدقون أنّ الإسلام يمتلك مثل هذه الخاصية؛ لذا فسنبيّن منها ما يكفي لإقناع المتشائمين وما يصلح نموذجا جيّداً أمام الآخرين.
ومن أجل أن يعلم القرّاء المحترمون أنّ مثل هذه البحوث لم تكن خافية على علماء الإسلام، فليراجعوا الكتاب النفيس المسمّى (تنبيه الأُمّة) تأليف العلاّمة المرحوم آية الله النائيني (أعلى الله مقامه) والمقالة القيّمة (ولايت وزعامت) أي: (الولاية والزعامة) للأُستاذ والعلاّمة الكبير المعاصر السيد الطباطبائي (مدّ ظله)(1) في كتاب (مرجعيت وروحانيت) أي (المرجعية ورجال الدين) وكلا الكتابين باللغة الفارسية.
إنّ السرّ في انسجام الدين الإسلامي المقدّس - بقوانينه الثابتة التي
____________________
(1) توفّي العلاّمة الطباطبائي عام 1402هـ، الموافق لعام 1981م.
لا تقبل الغيير - مع التطوّر الحضاري والثقافي ومواءمته للصور الحياتية المتغيّرة يكمن في عدّة أمور سنقوم بشرح بعضها فيما يلي:
1 - الاهتمام بالجوهر والمعنى وإهمال القالب والشكل
إنّ الإسلام لم يهتم بالشكل الظاهر للحياة والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالميزان العلمي للإنسان، بل إنّ القوانين الإسلامية تتعلّق بالروح والمعنى، وبهدف الحياة وأفضل السبل التي يجب ان يسلكها البشر لتحقيق ذلك الهدف، اما العلم فلا يغير هدف الحياة وروحها، ولا يهدي إلى طريق أفضل وأقصر وأسلم للوصول إلى هذا الهدف، إنّما يهيّئ أساليب أفضل وأكمل للوصول إليه، ويضيء الطرق التي يهدي إليه.
إنّ الإسلام بتحديده الأهداف ضمن منطقة اختصاصه، وتركه الإشكال والصور والآلات لتقع ضمن منطقة اختصاص العلم والفن، لم يتعارض مع أيّ شكل من إشكال التطوّر الثقافي والحضاري، بل شجّع على تطوير الحضارة بالعلم والعمل والتقوى والإرادة والهمّة والاستقامة، وقد تبنّى دور العامل الأساس في تقدّم الحضارة.
إنّ الإسلام قد نصب معالم في خط سير الإنسان، هذه المعالم أشارت من ناحية إلى الطريق والغاية، ومن ناحية أُخرى أشارت بعلامة الخطر إلى الانحرافات والمساقط والمفاسد؛ فجميع التعاليم الإسلامية هي إمّا من معالم النوع الأوّل أو من معالم النوع الثاني.
إنّ وسائل وآلات المعيشة في كل عصر ترتبط بكمّيّة المعلومات
والاطلاعات* العلمية للإنسان، فبمقدار ما تنمو المعلومات والاطلاعات، تتكامل الآلات وتأخذ مكان النواقص بحكم حتمية التاريخ.
في الإسلام، لا يمكن أن نجد أداة أو تشكيلة مادية ذات (قدسية) لكي يجد حتى فرد واحد نفسه ملزماً بالاحتفاظ بها.
إنّ الإسلام لم يقل إنّ الخياطة أو النساجة أو الزراعة أو الحمل والنقل أو الحرب أو أي عمل آخر من هذا القبيل يجب أن يتم بالآلة الفلانية حتى إذا أُلغيت تلك الآلة نتيجة لتقدّم العلم، شبّ نزاع واختلاف بين العلم وقانون الإسلام. إنّ الإسلام لم يحدد أنماطاً خاصة بالحذاء واللباس، ولا طرازاً معيناً للبناء ولا آلات خاصة للانتاج والتوزيع. لذلك فهو ينسجم مع تطور ورقي العصر.
2 - قانون ثابت للحاجة الثابتة وقانون متغيّر للحاجة المتغيّرة
والخاصية الأُخرى من خصائص الدين الإسلامي الفائقة الأهمّيّة هي أنّه قد وضع قوانين ثابتة لاحتياجات الإنسان الثابتة، وقوانين متغيرة لاحتياجات الإنسان المتغيرة، فإنّ قسماً من الحاجات سواء على الصعيد الفردي والشخصي أو على الصعيد العام والاجتماعي ذات وضع ثابت، فهي واحدة في جميع العصور. فالنظام الذي يجب أن يحكم غرائز الإنسان، والنظام الذي يجب أن يحكم مجتمع الإنسان - من
____________________
* لا يخفى على القارئ أنّ هذه المفردة ليست عربية الاشتقاق على الرغم من كون مادتها عربية. [ الشبكة ].
حيث الأصول والضوابط العامة - واحد في جميع الأزمان.
إنّني واع لمسألة (نسبية الأخلاق) ومسألة (نسبية العدالة) اللتين تملكان رصيداً من المؤيّدين، وسأبيّن رأيي آخذاً بنظر الاعتبار نظريات هؤلاء المؤيّدين.
وقسم آخر من حاجات الإنسان متغيّرة وتستوجب قوانين متغيّرة وغير ثابتة. والإسلام بالنسبة لهذه الحاجات المتغيّرة قد أخذ بنظر الاعتبار أوضاعاً متغيّرة وذلك بربط هذه الأوضاع المتغيّرة بمبادئ ثابتة، وهذه المبادئ تنشئ لكل وضع متغير قانوناً فرعياً خاصاً.
إنّني لا استطيع أن أوضح هذه المسألة أكثر من ذلك ضمن هذه المقالة، لكنّني سأضرب للقرّاء المحترمين بعض الأمثلة.
في الإسلام مبدأ اجتماعي يتمثّل بقوله تعالى:( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ) (1) ، وفي السنّة النبوية مجموعة من التعليمات تعرف في الفقه باسم: (السبق والرماية).
ورد في الحديث ما معناه: علّموا أولادكم فنون الفروسية والرماية حتى تتقنوها. وكان ركوب الخيل والرماية من الفنون العسكرية في ذلك العصر. وواضح جداً أنّ جذر ومبدأ قانون (السبق والرماية) هو نفس مبدأ( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ) أي أنّ الرمح والسيف والسهم
____________________
(1) سورة الأنفال، الآية 60.
والخيل ليست هي الأصل في القوّة في نظر الإسلام. أمّا الأصالة للقوّة. الأصالة أن يصبح المسلمون في كل عصر وزمان أصحاب قوّة في النواحي العسكرية والدفاعية أمام الأعداء وإلى أقصى حدّ ممكن. فلزوم المهارة في الرماية وركوب الخيل إطار لمسألة لزوم القوّة. بتعبيرٍ آخر: هو صورة تنفيذية لها غير. إذاً فشرط القوّة أمام العدو قانون ثابت ينبع من حاجة ثابتة ودائمة. أمّا شرط المهارة في الرماية وركوب الخيل فمظهر لحاجة مؤقّته ومتغيّرة تتغيّر من عصر إلى عصر، وبتغيّر ظروف الحضارة تحل محلّها أمور أخرى من قبيل الأسلحة النارية المتداولة هذه الأيام والمهارة والتخصّص في استعمالها.
مثال آخر: مبدأ اجتماعي آخر ذكر أيضاً في القرآن يتعلّق بتبادل الثروة؛ فالإسلام قبل مبدأ الملكية الفردية، وبالطبع فإنّ ما قبله الإسلام بعنوان الملكية يختلف عمّا هو موجود في العالم الرأسمالي، وليس الآن وقت المقارنة بينهما، وشرط الملكية الفردية هو التبادل.
وقد قرّر الإسلام (للتبادل) مبادئ من جملتها مبدأ:( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) (1) . أي أنّ المال والثروة المتداولة من يد إلى يد والتي تخرج من يد المنتج وصاحب الصلاحية في مقابل فائدة مشروعة تعود على صاحب الثروة، أمّا انتقال الثروة من يد إلى يد بدون أن تعود على صاحبها بفائدة ذات قيمة إنسانية فهو أمر ممنوع؛ فالإسلام لا يعتبر
____________________
(1) سورة البقرة، الآية 188.
الملكية مساوية للصلاحية المطلقة.
من ناحية أُخرى، ورد في التعاليم الإسلامية منع بيع وشراء بعض الأشياء، ومن جملتها الدم وغائط الإنسان، لماذا؟ لأنّ دم الإنسان أو الخروف ليس لهما استعمال مفيد يجعلهما ذوي قيمة وجزءاً من ثروة الإنسان، ومبدأ منع بيع وشراء الدم والغائط يستند إلى مبدأ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) . فمنع بيع الدم والغائط ليس له أصالة في نظر الإسلام، إنّما الأصالة لوجوب كون التبادل بين شيئين نافعين للإنسان، فمنع بيع أمثال دم وغائط الإنسان اصطبغ بصبغة منع تداول الثروة بالباطل. وبتعبير آخر: إنّها لا صورة التنفيذية لمبدأ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) بل لو لم تكن هناك مبادلة أصلاً فلا يمكن لأيّة ثروة أن تمتلك من الغير بالباطل وتُصرف.
هذا المبدأ هو مبدأ ثابت لكل عصر وينبع من حاجة اجتماعية ثابتة، أمّا كون الدم والغائط لا يعدّان مالاً وغير قابلين للتبادل فأمر يرتبط بالعصر والزمان والمستوى الحضاري، وبتغيّر الظروف وتقدّم العلوم والصناعات وإمكان استعمالها لفائدة الإنسان يتغيّر هذا الحكم.
مثال آخر: كان أمير المؤمنين علي (عليه السلام) في أواخر عمره - لا يستعمل الأصباغ بالرغم من بياض شعره. فكانت لحيته وشارباه بيض. فقال له رجل ألم يقل رسول الله (صلّى الله عليه وآله): (غطّوا الشعر الأبيض بالصبغ) فقال (عليه السلام): (نعم)، قال الرجل فلماذا لا تصبغ شعرك؟ قال (عليه السلام): (حين أمر رسول
الله (صلّى الله عليه وآله) بذلك كان عدد المسلمين قليلاً وكان بينهم عدد من الشيوخ يشاركون في الحروب، فإذا نظر العدو إلى صفوف المسلمين ورأى أُولئك الشيبة سكن روعه وقويت معنوياته؛ لأنّه يقاتل شيوخاً فأمر الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله) أن يصبغوا شعرهم كي لا يتنبّه العدو إلى سنّهم. فعندها ذكر الإمام علي (عليه السلام) أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إنّما أمر بذلك حين كان عدد المسلمين قليلاً، وكان لابد من ممارسة مثل هذه الأساليب. أمّا اليوم فقد انتشر الإسلام في أقطار العالم ولم تعد هناك حاجة لهذا العمل، فكل شخص حر في أن يصبغ شعره أو لا يصبغه.
في نظر علي (عليه السلام) أنّ أمر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أن: (اصبغوا شعوركم) لم تكن له أصالة؛ فالشكل التنفيذي كان قانوناً آخر غلّف به القانون الأساسي الذي هو عدم تقوية معنويات العدد.
إنّ الإسلام يهتم بالشكل والمظهر والخارج، كما يهتم بالروح والباطن والجوهر لكنّه إنّما يطلب الشكل والمظهر للروح والباطن، يطلب الغلاف من أجل النواة، ويطلب القشر من أجل اللب، واللباس من أجل الجسد.
مسألة تغيير الخط
طرحت في بلادنا هذه الأيام مسألة (تغيير الخط). هذه المسألة في الوقت الذي يمكن بحثها من ناحية اللغة والأدب الفارسي، كذلك يمكن بحثها من وجهة نظر المبادئ الإسلامية. ويمكن طرح هذه المسألة من
وجهة نظر الإسلام على صورتين.
الأُولى: هل للإسلام ألف باء خاصة به وهل يفرق بين الألفباءات؟ وهل يعتبر الإسلام ألفباءنا - المعروفة اليوم باسم الألف باء العربي - خاصة به ويعد الألفباءات الأخرى كالألف باء اللاتينية أجنبية؟ بالطبع لا. فالإسلام الذي هو دين عالمي يعتبر كل الألفباءات سواء.
الثانية: ما تأثير تغيير الخط والألف باء في اجتذاب وذوبان الأمة الإسلامية في الأجانب؟ ما تأثيره في قطع علاقة هذه الأمّة بثقافتها إذا علمنا أنّ المعارف الإسلامية والعلمية لها قد كتبت بهذه الألف باء طوال أربعة عشر قرناً؟ ومَن الذي اقترح خطّة تغيير الخط؟ ومَن الذي ينفّذها؟ هذا ما يجب أن نبحثه الآن.
التطفّل حرام وليس لبس القبعة
يواجه أمثالي أحياناً بأسئلة تخالطها لهجة احتقار واستهزاء، يسألونني: ما حكم الشرع في تناول الطعام وقوفاً؟ وما هو حكم استعمال الشوكة والملعقة؟ وهل اعتمار القبعة حرام؟ وهل استعمال لغة أجنبية حرام؟
فأجيب قائلاً: إنّ الإسلام لم يضع لهذه الأُمور حدوداً خاصّة، إنّه لم يقل كل بيدك، ولا قال: كل بالملعقة، إنّما قال حافظ على النظافة على كل حال. ومن ناحية القبعة والحذاء واللباس كذلك لم يأت الإسلام (بموضة) خاصة. وفي نظر الإسلام أنّ اللغة الانكليزية واليابانية
والفارسية شيء واحد، ولكن...
ولكنّ الإسلام قال شيئاً آخر، إنّه قال: إنّ ذوبان الشخصية حرام. الخوف من الآخرين حرام. التقليد الأعمى حرام. الذوبان والتلاشي في الآخرين حرام. التطفّل حرام. الانخداع بالأجانب كانخداع الأرنب بالحيّة حرام. تصوّر الحمار الأجنبي الميت بغلاً حرام. قبول انحرافاتهم ومآسيهم باسم (ظاهرة القرن) حرام. اعتقاد أنّ الإيراني يجب أن يصبح إفرنجياً جسماً وروحاً وظاهراً وباطناً حرام. والإقامة أربعة أيام في باريس وتبديل مخرج (الراء) بمخرج (الغين) وقول (غحت) بدلاً من (رحت) حرام.
3 - مسألة الأهم والمهم
وأمر آخر من الأمور التي مكّنت الإسلام من الانسجام مع مقتضيات العصر هو جانب في تعاليم هذا الدين. فالإسلام أبلغ أتباعه أنّ كل تعاليمه ناشئة عن مجموعة مصالح عليا، ومن الناحية الأخرى توضّحت في الإسلام درجة أهمّية المصالح، هذا الأمر يسّر عمل خبراء الإسلام الحقيقيين في المجالات التي تتعارض فيها المصالح المختلفة. فقد أجاز الإسلام في مثل هذه الموارد، أن يقوم الخبراء الإسلاميون بالموازنة بين درجة أهميّة المصالح، ومن ثمّ اختيار المصلحة الأهم على أساس من التوجيهات التي وضعها الإسلام نفسه. ويسمّي الفقهاء هذه القاعدة باسم (الأهم والمهم). ولديّ هنا أمثلة كثيرة
لكنّني أعرض عن ذكرها.
4 - القوانين التي تمتلك حق النقض (الفيتو)
وأمر آخر يمنح هذا الدين قابلية المرونة والانسجام ويجعله حيّاً خالداً هو أنّ هناك مجموعة من القواعد والقوانين شُرّعت ضمن هذا الدين، عملها الإشراف والسيطرة على القوانين الأخرى، ويسمّي الفقهاء هذه القواعد بالقواعد (الحاكمة)، مثل قاعدتي (لا حرج) و(لا ضرر) اللتين تحكمان الفقه كلّه. عمل هذه المجموعة من القواعد هو السيطرة وتعديل القوانين الأخرى. وفي الحقيقة أنّ الإسلام جعل لهذه القواعد حق النقض (الفيتو) بالنسبة لسائر القوانين والتعليمات؛ ولذلك أيضاً قضية طويلة ليس هنا محلّ ذكرها.
صلاحيات الحاكم
بالإضافة إلى ما ذُكر هناك مجموعة (روابط وفواصل) أخرى في بناء دين الإسلام المقدّس منحت هذا الدين خاصية الخلود والخاتمية، وقد اعتمد المرحوم آية الله النائيني وحضرة العلاّمة الطباطبائي في هذا المجال كثيراً على الصلاحيات التي أعطاها الإسلام للحكومة الإسلامية الصالحة.
مبدأ الاجتهاد
يقول الشاعر الباكستاني إقبال: (الاجتهاد هو القوّة المحرّكة للإسلام) هذا الكلام سليم إلاّ أنّ الشيء الأساس هو خاصية الإسلام في
(استيعاب الاجتهاد). فلو وضعنا بدل الإسلام شيئاً آخر؛ لرأينا أنّ أمر الاجتهاد صعب جدّاً بل لا سبيل إلى وجوده، لكنّ الأساس هو هذه الأسرار التي خالطت بناء هذا الدين السماوي العجيب ومنحته القابلية على الانسجام مع التقدّم الحضاري.
ويبيّن ابن سينا في (الشفاء) كذلك ضرورة (الاجتهاد) على نفس هذا المبدأ يقول: (لما كانت أوضاع الزمان متغيّرة وتطرأ على الدوام مسائل جديدة، ومن جهة أخرى فإنّ مبادئ الإسلام الكلية ثابتة لا تتغيّر، لذا أصبح من الضروري أن يوجد في جميع العصور والأزمان أفراد ذوو معرفة وخبرة كاملة بالمسائل الإسلامية يأخذون بنظر الاعتبار المسائل الجديدة التي تطرأ في كل عصر، ويتجاوبون مع احتياجات المسلمين).
وملحق القانون الأساسي لإيران قد أخذ بنظر الاعتبار أيضاً، أن تكون هناك في كل عصر هيأة من المجتهدين لا يقل عددهم من خمسة أشخاص (لهم معرفة بمقتضيات العصر) للإشراف على القوانين. وغرض كتاب هذه المادة وجود أفراد غير (جامدين) ولا (جاهلين)... غير معارضين للتقدّم العصري ولا مقلّدين للآخرين، يشرفون على قوانين الدولة. ويجب أن أؤكّد على نقطة مهمة هي أن (الاجتهاد) بالمفهوم الحقيقي للكلمة يعني التخصّص والمعرفة في المسائل الإسلامية، وليس شيئاً يمكن أن يدّعيه كل هارب من المدرسة؛ لأنّه حضر لعدّة أيام في إحدى الحوزات العلمية. وممّا لا شك فيه أنّ التخصّص في المسائل الإسلامية وصلاحية إعطاء الآراء فيها يتطلّب
مجهود عمر، وإن لم يكن العصر قصيراً لنيل ذلك فهو ليس كثيراً عليه. هذا مع اشتراط أن يكون الشخص المشار إليه ذا قابليّة واستعداد كبيرين، وممّن كتب الله له التوفيق لبلوغ هذا الأمر.
وبغضّ النظر عن التخصّص والاجتهاد، يمكن لبعض الأفراد أن يكونوا مراجع لطرح الآراء والنظريات الإسلامية إذا كانوا قد بلغوا الحدّ الأعلى في التقوى ومعرفة الله وخشيته. فإنّ تاريخ الإسلام يرينا أفراداً مع ما كانوا يتمتّعون به من مستويات علمية وأخلاقية عالية، إلاّ أنّهم حين كانوا يهمّون بالإفتاء والتوجيه يرتجفون كالصفصاف. وأعتذر ثانية من القرّاء المحترمين لأنّ البحث قد جرّنا إلى الكلام في مثل هذه الأمور.
الفصل الخامس
القرآن ومكانة المرأة
المكانة الإنسانية للمرأة في نظر القرآن
كيف ينظر الإسلام إلى المرأة كمخلوق؟
هل يعتبرها من حيث الشرف والكرامة الإنسانية مساوية للرجل، أم يعتبرها جنساً أدنى؟
هذا ما سنجيب عنه فيما يلي:
فلسفة الإسلام الخاصّة بحقوق الأُسرة
للإسلام في مجال الحقوق الأُسرية للمرأة والرجل فلسفة خاصة تختلف عمّا كان سائداً قبل أربعة عشرة قرناً، وعمّا هو سائد في العالم الآن. إنّ الإسلام لا يرى للمرأة والرجل من جميع المجالات نوعاً واحداً من الحقوق، ولا نوعاً واحداً من الواجبات، ولا نوعاً واحداً من العقوبات. إنّما يرى قسماً من الحقوق والواجبات والعقوبات أنسب للرجل، وقسماً غيرها أنسب للمرأة، وبالنتيجة فقد جعل في بعض المجالات وضعاً متشابهاً للمرأة والرجل، وفي مجالات أُخرى وضعاً مختلفاً.
فلماذا؟ وعلى أيّ أساس؟ وهل إنّ الإسلام - ككثير من المدارس الفكرية الأخرى - ينظر إلى المرأة نظرة احتقار، ويعتبرها جنساً أدنى؟
أم أنّ له في ذلك رأياً آخر وفلسفةً أخرى؟
لقد سمعتم وقرأتم مراراً وتكراراً أحاديث وكلمات وكتابات مقلّدي النظم الغربية، وفيها أنّ مقرّرات الإسلام في المهر والنفقة والطلاق وتعدّد الزوجات وأمثالها ليست إلاّ دليلاً على احتقار وإهانة المرأة والتزام جانب الرجل فقط.
يقولون: إنّ جميع نظم وقوانين العالم قبل القرن العشرين تقضي بأنّ الرجل أشرف جنساً من المرأة، وأنّ المرأة خُلقت من أجل استمتاع الرجل، وأنّ الحقوق الإسلامية تدور كذلك حول محور مصالح ومنافع الرجل.
ويقولون: الإسلام دين الرجال، وأنّه لا يعتبر المرأة إنساناً كاملاً، ولم يضع لها حقوقاً كما يجب للإنسان؛ إذ لو اعتبرها إنساناً كاملاً لما أجاز تعدّد الزوجات، ولما أعطى حق الطلاق للرجل، ولما اعتبر شهادة امرأتين بمثابة شهادة رجل واحد، ولما أسند رئاسة العائلة إلى الرجل، ولما جعل سهم المرأة من الإرث نصف سهم الرجل، ولما جعل للمرأة ثمناً اسمه المهر، ولمنحها استقلالاً اقتصادياً واجتماعياً، ولما جعلها مرتزقة عند الرجل وجعل نفقتها واجبة عليه. ويتوصّلون بكل ذلك إلى أنّ الإسلام ينظر إلى المرأة باحتقار، ويعتبرها أداةً بيد الرجل.
ويقولون: إنّ الإسلام مع أنّه دين المساواة، وقد راعى مبدأ المساواة في بعض الأمور، إلاّ أنّه لم يراع هذا المبدأ فيما يتعلّق بالمرأة والرجل.
ويقولون: إنّ الإسلام منح الرجل امتيازاً وتفضيلاً في الحقوق، ولو لم يكن كذلك لما وقف من المرأة المواقف السالفة الذكر.
ولو أردنا أن نصوغ اعتراضات هؤلاء السادة صياغةً منطقيةً أرسطيّة فإنّها ستأتي على الشكل التالي:
لو أنّ الإسلام اعتبر المرأة إنساناً كاملاً، لمنحها حقوقاً متشابهة ومتساوية لحقوق الرجل، وبما أنّه لم يمنحها مثل هذه الحقوق، فهو إذن لا يعتبرها إنساناً حقيقياً.
مساواة أم تشابه؟
إنّ المبدأ الذي استند إليه المعترضون هو تلازم تساوي المرأة والرجل في الإنسانية مع وجوب تساويهما في الحقوق.
وهنا يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار مبدأً فلسفياً آخر هو:
ماذا يستلزم تساوي المرأة مع الرجل في الكرامة الإنسانية؟ هل يستلزم تساويهما في الحقوق بشكل ليس فيه تفضيل أو تمييز، أم أنّه يستلزم أن تكون المرأة والرجل علاوةً على التساوي متشابهين في الحقوق وليس بينهما تقسيم في الواجبات والأعمال؟
فنقول: إنّ ممّا لا شك فيه هو أنّ تساوي المرأة والرجل في الكرامة الإنسانية يستلزم تساويهما في الحقوق الإنسانية، أمّا أن يتشابها في الحقوق فذلك شيء آخر.
فإذا أردنا أن نتخلّى عن التقليد الأعمى لفلسفة الغرب، وأجزنا لأنفسنا أن نتأمّل في ما وصلنا منهم من أفكار وآراء فلسفية، فلننظر هل أنّ التساوي في الحقوق هو نفس التشابه في الحقوق أم لا؟ إنّ التساوي غير التشابه... التساوي هو المساواة، والتشابه هو المماثلة. فيمكن مثلاً أن يقسم أب ثري ثروته بين أولاده بالتساوي ولا يقسمها بشكل متشابهة. ففي هذا المثال يمكن أن يكون للأب عدّة أنواع من الثروات، يكون أحدها متجراً، وثانيها أرضاً زراعية، وثالثها أملاكاً مؤجّرة، ولكن بما أنّه كان قد اختبر مقدماً استعدادات كل من أولاده فوجد أنّ لأحدهم قابلية في العمل التجاري، وللثاني رغبة في الزراعة، وللثالث قابلية في إدارة الأملاك المؤجّرة، فإذا أراد أن يقسم ثروته بين أولاده في حياته فانه - مع الأخذ بنظر الاعتبار مراعاة التساوي في القيمة عند التقسيم - سيمنح أولاده من ثروته كلاًّ حسب ما وجد فيه من الاستعداد لإرادته والنجاح فيه.
فالكمّ غير الكيف، والتساوي غير التشابه والتماثل. فإنّ من المسلّم به أنّ الإسلام لم ينمح المرأة والرجل حقوقاً من نوع واحد ولون واحد لكنّه لم يفضل الرجل على المرأة في الحقوق. لقد راعى مبدأ المساواة في الإنسانية بين المرأة والرجل... الإسلام يقر المساواة بين حقوق المرأة والرجل ولكنّه لا يقر تشابه هذه الحقوق.
إنّ كلمات مثل: كلمة التساوي والمساواة - لكونها تتضمّن مفهوم
عدم التمييز - قد حازت على قدسية خاصّة، ولها جاذبية معيّنة، فهي تجتذب احترام السامع وخاصّة إذا أُضيفت إليها عبارة (في الحقوق) واقترنت بها.
المساواة في الحقوق! يا لها من تركيبه جميلة ومقدّسة. مَن هو الإنسان النظيف الفطرة والضمير الذي لا يخضع ولا ينحني إجلالاً أمام هذه العبارة؟
ولكن لا أدري كيف - ونحن الذين كنّا حملة لواء العلم والفلسفة والمنطق في العالم - وصل بنا الحال إلى درجة أنّ الآخرين يحاولون أن يفرضوا علينا نظرياتهم حول (تشابه حقوق المرأة والرجل) تحت هذا العنوان المقدّس (المساواة في الحقوق). إنّ هذا يشبه بالضبط أنّ شخصا يبيع (البنجر) وينادي عليه باسم (كمثرى).
فمن المسلّمات أنّ الإسلام لم يضع للمرأة والرجل في المجالات حقوقاً متشابهة، كما أنّه لم يضع عليهما في جميع المجالات تكاليف وعقوبات متشابهة، ولكن هل معنى ذلك أنّ مجموع الحقوق التي منحها للمرأة أقل قيمة وأهميّة من الحقوق التي منحها للرجل؟ بالطبع، لا. وهذا ما نبرهن عليه الآن. وهنا يبرز سؤال ثان، هو: لماذا شرع الإسلام حقوقاً غير متشابهة للمرأة والرجل في بعض المجالات؟ لماذا لم يجعلها جميعا متشابهة؟ هل من الأفضل أن تتساوى وتتشابه حقوق المرأة والرجل أم أن تتساوى ولا تتشابه؟
ولأجل بحث هذه المسألة بشكل كامل، نقسّم البحث إلى ثلاثة أقسام هي:
1 - نظرة الإسلام إلى المرأة كإنسانة من ناحية الخلقة.
2 - الهدف من وراء الاختلاف في الخلقة بين المرأة والرجل؟ وهل أنّ هذا الاختلاف يجب أن يؤدّي إلى اختلاف في الحقوق الطبيعية والفطرية بينهما أم لا؟
3 - ما هي فلسفة الفروق التي يضعها النظام الإسلامي بين المرأة والرجل، والتي يتعامل مع بعضها على أساس عدم التشابه؟ وهل أنّ هذه الفلسفة والحكمة من الاختلاف سارية المفعول إلى هذا اليوم، أم لا؟
مقام المرأة
أمّا في القسم الأوّل: فالقرآن ليس مجموعة قوانين فحسب، وإنّ محتويات القرآن ليست سلسلة مجرّدة من الأنظمة والقوانين الجافّة التي لا معنى لها. وإنّما في القرآن نجد القانون كما نجد التاريخ، والموعظة، وتبيان حكمة الخالق، وآلاف المسائل الأخرى. فالقرآن في الوقت الذي يشرّع القوانين من جهة، نجده في مكان آخر يتحدث عن الخلق والطبيعة من جهة أخرى. فهو يبين خلق الأرض والسماء والنبات والحيوان والإنسان وسر الموت والحياة، والعزّة والذلّة، والارتقاء والانحطاط، والغنى والفقر.
القرآن ليس كتاب فلسفة لكنّه يعطي رأياً قاطعاً حول الكون
والإنسان والمجتمع بشكل واضح، وهذه المسائل الثلاث تشكّل المواضيع الأساس للفلسفة.
إنّ القرآن لا يعلّم أتباعه قانوناً ولا يعظهم وعظاً مجردّاً وإنّما يوجد لديهم - عن طريق بيان حكمة الخلق - تصوّراً خاصّاً للكون والحياة، ويعلّمهم منهجاً جديداً للتفكير. وما أساس الأنظمة الإسلامية في الأمور الاجتماعية كالملكية والحكم وحقوق الأسرة إلاّ نظرته إلى الوجود والموجودات.
ومن جملة المسائل التي بيّنها القرآن الكريم موضوع خلق المرأة والرجل، فهو في هذا المجال لم يدع الجو خالياً للمتقوّلين كي يصوّروا موقف الإسلام بأنّه موقف احتقار للمرأة. وإنّما بادرهم ببيان موقفه منها بشكل واضح. وإذا أردنا أن نعرف نظرة القرآن حول خلق المرأة والرجل وجب علينا أن ننتبه إلى مسألة طبيعة وطينة كل من المرأة والرجل والتي أشارت إليها جميع الكتب الدينية، وكذلك القرآن لم يسكت هذا الموضوع.
فلننظر هل يتعامل القرآن مع المرأة والرجل على أنّهما من طينة وخلقة واحدة أم من طينتين مختلفتين؟
يذكر القرآن في آيات عديدة بصراحة تامّة قول الله تعالى إنّه خلق النساء من جنس الرجال ومن طينة مشابهة لطينة الرجال، فيذكر عن آدم قوله جلّ وعلا:( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً... ) (1) .
ويعني بالنفس الواحدة نفس آدم (عليه السلام).
كما يذكر في سورة النساء وآل عمران آيات تتضمّن خلق الزوجة من جنس الزوج، ضمن استعراض نعم الله عزّ وجلّ على الإنسان، ولا تجد في القرآن أثراً لما تجده في كتب الأديان الأخرى من أنّ المرأة قد خُلقت من مادة أدنى من مادة الرجل، أو أنّ المرأة ناقصة الخلقة وأنّ حواء قد خُلقت من أحد أعضاء آدم (عليه السلام)؛ وعليه، نرى أنّه توجد في الإسلام نظرة احتقار تجاه المرأة في طبيعة خلقها وأصلها.
ونظرية أخرى من النظريات التي تحتقر المرأة، والتي كانت سائدة - فيما مضى - وتركت في أدب الشعوب آثاراً سيئة تلك التي تقول: المرأة هي عنصر الخطيئة ومن وجودها يدب الشر والفساد، وأنّ للمرأة يداً في كل جريمة وخطأ يرتكبه الرجال... فيقولون: إنّ الرجل في حدّ ذاته مبرّأ من الخطأ، وأنّ المرأة هي التي تجرّه إلى الخطيئة، ويقولون: إنّ الشيطان لا يجد طريقاً مباشراً إلى الرجل. وإنّما إلى المرأة التي تخدع الرجل بدورها، فالشيطان يوسوس للمرأة وهي توسوس للرجل، ويقولون: إنّ آدم (عليه السلام)، الذي خدعه الشيطان وتسبّب في إخراجه من جنّة النعيم إنّما كان انخداعه عن طريق المرأة، فالشيطان خدع حوّاء وهي
____________________
(1) سورة النساء، الآية 1.
أغرت آدم (عليه السلام).
هذا بينما نجد القرآن يطرح قصّة جنّة آدم بدون أن يشير أبداً إلى أنّ الشيطان أو الثعبان قد أغوت حواء، وأنّ حواء أغوت آدم، بل إنّه لا يجعل حواء مسؤولاً رئيسياً ولا يخرجها من الحساب. فالقرآن يقول:( يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا ) (1) ثم حين يتطرق إلى وسوسة الشيطان نجده يتحوّل إلى التثنية في الحديث فيقول:( فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ ) (2) و( فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ ) (3) و( وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ) (4) .
فيدخل القرآن حرباً ضد الأفكار التي كانت منتشرة في ذلك العصر، ويبرئ المرأة ممّا كان ينسب إليها من كونها عنصر وسوسة وخطيئة، وشيطاناً صغيراً.
ومن النظريات الأخرى التي تحتقر المرأة تلك التي تتعلّق باستعداداتها الروحية والمعنوية، فكانوا يقولون إنّ المرأة لا تدخل الجنّة، وأنّها لا تستطيع أن تسمو في المراتب الروحية والدينية، ولا أن تدرك ما يدركه الرجل في القرب من الخالق جلّ وعلا. هذا بينما نجد
____________________
(1) سورة البقرة، الآية 35.
(2) سورة الأعراف، الآية 20.
(3) سورة الأعراف، الآية 22.
(4) سورة الأعراف، الآية 21.
في القرآن آيات كثيرة تصرّح بأنّ الجزاء الأُخروي والقرب من الله لا يرتبط بجنس الفرد ذكراً أو أنثى، بل بالإيمان والعمل الصالح، سواء من قِبل المرأة أو من قِبل الرجل. ثم يضع القرآن إلى جانب كل رجل عظيم ومقدّس امرأة عظيمة ومقدّسة. فيذكر بكل تقدير زوجات آدم وإبراهيم، وأُمّهات عيسى وموسى. وإذا كان قد أشار إلى زوجتي نوح ولوط على أنّهما زوجتان غير صالحتين فقد أشار إلى زوجة فرعون على أنّها امرأة عظيمة ابتُليت برجلٍ فاجر، وكأنّ القرآن قد حفظ في قصصة التوازن بين المرأة والرجل ولم يقصر البطولة على الرجال فقط.
يقول القرآن في حديثه عن أُمّ موسى:
( وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ... ) (1) .
ولا يخفى ما في العبارة من الدلالة على مكانتها إذ يوحي إليها الله العلي القدير.
ويتحدث عن مريم والدة عيسى (عليهما السلام) كيف كانت الملائكة تحدثها في المحراب، وكيف كان رزقها يأتيها عن طريق الغيب حيث يدل على ما بلغته من رتبة ربّانية عالية حتى أن نبي زمانها احتار في أمرها وتجاوزته هي في درجتها عند الله وبقي زكريا مبهوتاً أمامها.
وفي التاريخ الإسلامي ذاته قدّيسات كثيرات وجليلات إذ لم يبلغ
____________________
(1) سورة القصص، الآية 7.
الدرجة التي بلغتها خديجة الكبرى (رض) من الرجال إلاّ القليل، كما لم يبلغ درجة الزهراء (سلام الله عليها) رجل غير الرسول (صلّى الله عليه وآله) والإمام علي (عليه السلام) فهي أفضل من أبنائها على أنّهم أئمّة، وأفضل من كل الأنبياء غير رسول الله (صلّى الله عليه وآله). والإسلام لا يرى فرقاً بين الرجل والمرأة في سيرهما التكاملي نحو الله عزّ وجل، بل الفرق الوحيد الذي وضعه الإسلام في مسيرة الإنسان نحو الحق هو اختياره الرجل لتحمّل مسؤولية النبوّة والرسالة وهداية الناس إلى الحق، إذ نظر إلى الرجل على أنّه الأنسب لهذا الأمر.
ومن النظريات الأُخرى التي كانت تحتقر المرأة تلك التي تتعلّق بالرياضة الجنسية وتقدّس العزوبية إذ إنّ العلاقة الجنسية - كما نعلم - تعتبر في بعض الشرائع قذرة في حدّ ذاتها. وأتباع هذه الشرائع يعتقدون أنّ الإنسان لا يبلغ الرتب الروحية العالية إلاّ إذا قضى عمره أعزباً.
يقول أحد زعماء الأديان في العصر الحديث: (اقلعوا شجرة الزواج بمطرقة البكارة). ونفس هؤلاء الزعماء والقادة الدينيين قد يجيزون الزواج لبعض أتباعهم من باب اختيار أهون الشرّين. فهم يدّعون أنّ الأفراد بما أنّهم غالباً لا يطيقون حياة العزوبة، والصبر عن الزواج، فيفقدون من أيديهم زمام أمرهم ويتردّون في الفحشاء ممّا يؤدي إلى اتصالهم بعدّة نساء، فمن الأفضل إذن أن يجيزوا لهم الزواج لكي يضمنوا اتصالهم بامرأة واحدة فقط. وأساس فكرة الرياضة الجنسية والعزوبة ما
هو إلاّ سوء الظن بالعنصر النسائي واعتبار الميل نحو المرأة من المفاسد الأخلاقية العظمى.
وقد حارب الإسلام هذه الخرافة بشدّة واعتبر الزواج أمراً مقدّساً والعزوبة انحطاطاً، وجعل حبّ المرأة من أخلاق الأنبياء، فورد: (من أخلاق الأنبياء حب النساء) وقال الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله): (حُبّب إليّ من دنياكم: الطيب، والنساء، وقرّة عيني الصلاة).
يقول برتراند رسل: (في جميع الأديان نوع من التشاؤم وسوء الظن تجاه العلاقة الجنسية ما عدا الإسلام، إنّه قد وضع لهذه العلاقة ضوابط وحدوداًَ لصالح المجتمع ولم يستقذرها على الإطلاق).
ومن النظريات التي تحتقر المرأة تلك التي تقول: (إنّ المرأة خُلقت من أجل الرجل وهي لعبة بيده).
أمّا الإسلام فلم ترد فيه مثل هذه أبداً، بل يوضح بكل صراحة مبدأ العلّيّة، ويقول بوضوح كامل إنّ الأرض والسماء والسحاب والرياح والنبات والحيوان خُلقت كلّها من أجل الإنسان لم يقل مطلقاً إنّ المرأة خُلقت من أجل الرجل، نعم، قال إنّ المرأة والرجل قد خُلق كلٌّ منهما للآخر:( هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ) (1) .
ولو اعتبر القرآن أنّ المرأة خلقت من أجل الرجل، لظهر ذلك في
____________________
(1) سورة البقرة، الآية 187.
القوانين التي شرعها، ولكن لعدم وجود مثل هذه النظرة عند الإسلام في بيان حكمة الخلق، وعدم اعتباره المرأة تابعة لوجود الرجل، لم يظهر أيّ أثر لذلك في مواقفه الخاصة تجاه المرأة والرجل.
ومن النظريات القديمة التي كانت تحتقر المرأة أيضاً هي: (إنّ المرأة من وجهة نظر الرجل شرّ لابدّ منه) فكان كثير من الرجال على الرغم ممّا يجنونه من فوائد من وجود المرأة إلى جانبهم، إلاّ أنّهم يحتقرونها وينظرون إليها على أنّها أساس تعاستهم وبؤسهم، بينما نجد القرآن يناقش هذا المطلب بالذات فيعتبر وجود المرأة باب خير للرجل، وأساس سكنه وهدوء باله( ... لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا... ) (1) .
ومن النظريات ما كانت تغفل دور المرأة وأثرها في النسل والأولاد، فقد كان عرب الجاهلية وبعض الأُمم الأُخرى ينظرون إلى المرأة على أنّها وعاء لنطفة الرجل ولا يعدو دورها الاحتفاظ بهذه النطفة وإنماءها. بينما يقول القرآن الكريم:( يَا أَيّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ... ) (2) . فيساوي في الخطاب والمنزلة بين المرأة والرجل، وهذا ما دلّل عليه في كافة خطاباته للمرأة والرجل في كافّة المواضيع ممّا أدّى
____________________
(1) سورة الروم، الآية 21.
(2) سورة الحجرات، الآية 13.
في النهاية إلى القضاء على هذه النظرة عند الشعوب التي آمنت بالإسلام.
يتبيّن ممّا تقدم أنّ الإسلام من ناحية النظرة الفلسفية وأسباب الخلق لا يتضمّن نظرة احتقار إلى المرأة بل إنّه ردّ على النظريات التي تحتقر المرأة وفنّدها.
والآن جاء دور معرفة الحكمة من وراء عدم تشابه حقوق المرأة وحقوق الرجل في الإسلام.
لا للتشابه... نعم للمساواة
قلنا إنّ للإسلام فلسفة خاصة حول علاقات وحقوق المرأة والرجل تختلف عمّا كان سائداً قبل أربعة عشر قرناً كما تختلف عمّا هو سائد في العالم هذا اليوم.
وقلنا إنّ مسألة تساوي المرأة والرجل في الإنسانية من وجهة نظر الإسلام مسألة غير قابلة للنقاش، أمّا هل إنّ حقوقهما الأُسرية متساوية أم لا؟ فإنّ المرأة والرجل في نظر الإسلام إنسانان كاملا الإنسانية، ويتمتعان بنفس الدرجة من حقوق الإنسان، لكن الذي يطرحه الإسلام هو أن المرأة بما أنّها امرأة تختلف عن الرجل لكونه رجلاً في جوانب كثيرة، فعالم المرأة غير عالم الرجل، وخلقة وطبيعة المرأة غير خلقة وطبيعة الرجل. وهذا يؤدّي بالطبع إلى أنّ كثيراً من الحقوق والواجبات والعقوبات سوف لا تكون واحدة لكليهما.
في دنيا الغرب اليوم، سعي حثيث لمساواة المرأة والرجل في القوانين والأنظمة والحقوق والواجبات مع تجاهل الاختلافات الغريزية والطبيعية بينهما.
والاختلاف بين النظرة الإسلامية والنظم الغربية يكمن في هذه النقطة، وعليه نقطة الاختلاف في بلادنا بين مؤيّدي الحقوق الإسلامية من جهة، وأتباع النظم الغربية من الجهة الأُخرى هي في مسألة تشابه حقوق المرأة والرجل وليس في مسألة المساواة بينهما وما كلمة (المساواة) إلاّ شعار مزيّف يطلقه مقلّدو الغرب وعلامة تجارية يلصقونها على هذه البضاعة الغربية.
وقد كنت أتجنّب في كل كتاباتي وندواتي وأحاديثي استعمال هذه العلامة المزيّفة، وكنت أذكّر دائماً بأنّها ليست إلاّ دعوة لتشابه وتماثل حقوق المرأة والرجل تُطرح باسم المساواة.
أنا لا أدّعي أن دعوات المساواة بين المرأة والرجل لا معنى لها في أي مكان في العالم، وأنّ جميع قوانين العالم قديماً وحديثاً قد وضُعت على أساس حق المساواة ولم تفتقد إلاّ تشابه الحقوق.
كلاّ، أنّا لا أدعي هذا، وأوروبا ما قبل القرن العشرين أحسن شاهد على ذلك. ففي أوروبا ما قبل القرن العشرين كانت المرأة فاقدة للحقوق الإنسانية قانوناً وعملياً. إذ لم تكن لها حقوق مساوية أو مشابهة لحقوق الرجل... بل من خلال النهضة السريعة التي حدثت أخيراً في أقل من
قرن باسم المرأة ومن أجل المرأة حصلت على حقوق مشابهة تقريباً لحقوق الرجل. ولكنّها لم تحصل على حقوق مساوية لحقوق الرجل لو أخذنا بنظر الاعتبار وضعها الفيزيائي والفيزيولوجي؛ لأنّ المرأة إذا أرادت أن تحصل على حقوق كحقوق الرجل وعلى سعادة مساوية لسعادة الرجل، طريقها الوحيد هو أن تترك تشابه الحقوق وتطلب أن تكون للرجل حقوقه المناسبة له وتكون لها حقوقها المناسبة لها، وهذا هو السبيل الأمثل لحصول الوحدة والإخلاص الحقيقي بين الرجل والمرأة، والذي تدرك به المرأة مساوية بل أكثر من سعادة الرجل ويؤدّي إلى أن يحرص الرجال بكل إخلاص، وبدون خداع للمرأة على إتاحة حقوق لها مساوية لحقوقهم بل أكبر من حقوقهم.
كذلك فأنا لا أدّعي أنّ للمرأة في مجتمعنا - الإسلامي المظهر - اليوم حقوقاً مساوية لحقوق الرجال وقد قلت مراراً وتكراراً أنّ من الواجب والضروري أن نهتم بوضع المرأة في مجتمعنا، وأن نعيد إليها الحقوق التي منحها الإسلام لها، والتي سُلبت إيّاها طيلة العهود التاريخية السابقة دون أن نقلّد تقليداً أعمى الطراز الغربي الذي جرّ على الغربيين أنفسهم آلاف المآسي والتعاسات، فنكون قد وضعنا اسماً جميلاً لفرضية خاطئة فنضيف مصائب الغرب إلى مصائبنا نحن الشرقيين. ولكنّنا ندعو إلى عدم تشابه حقوق المرأة والرجل في المجالات التي تختلف فيها طبيعة كل منهما فننسجم بذلك مع العدل والحق الفطريين، ونؤمن بشكل أفضل سعادة الأُسرة، وندفع بالمجتمع إلى إمام.
وأرجو الانتباه جيداً إلى أنّ ما ندّعيه الآن هو أنّ العدالة والحقوق الفطرية والإنسانية تستدعي عدم تشابه المرأة والرجل في بعض الحقوق لا غير. فبحثنا الحالي بحث فلسفي مائة بالمائة، مجاله فلسفة الحقوق، وهو يرتبط بمبدأ اسمه (مبدأ العدل) والذي هو أحد أركان الكلام والفقه الإسلاميين. ومبدأ العدل هو الذي أوجد قانون التطابق بين العقل والشرع في الإسلام، وهذا يعني في الفقه الإسلامي - أو الفقه الشيعي على الأقل - أنّه إذا ثبت أنّ العدل يتطلّب أن يكون القانون الفلاني على صورة معيّنة وليس على صورة أخرى وإلاّ فإنّه ظلم وخلاف العدل؛ فيجب أن نقرّ القانون على الصورة التي اقتضاها العدل، لا على الصورة المغايرة.
وعلى هذا فإنّ الشريعة الإسلامية وطبقاً للمبدأ الذي طرحته هي ذاتها، لن تخرج مطلقاً على محور العدالة والحقوق الفطرية والطبيعية.
وقد وضع علماء الإسلام - ببيان مبدأ العدل - أساس فلسفة الحقوق، ولكنّهم - بتأثير المعوّقات المختلفة على مر التاريخ - لم يستطيعوا أن يضمنوا تطبيق هذا المبدأ دائماً على الواقع الاجتماعي. وأنّ الاهتمام بحقوق البشر وبمبدأ العدالة على أنّها أمور ذاتية وتكوينية خارجة عن نطاق القوانين الوضعية كان لأول مرة بمبادرة من المسلمين، وهم الذين وضعوا أساس الحقوق الطبيعية والعقلية، ولكن لم يكن من المقدر لهم أن يستمرّوا في طريقهم الذي بدأوه، فكان أن جاء
علماء وفلاسفة أوروبا بعد ما يقارب الثمانية قرون ليقلّدوا علماء الإسلام الأوائل، وينسبوا علمهم لأنفسهم، فطرحوا لمجتمعهم فلسفات اجتماعية وسياسية واقتصادية من جهة، ومن جهة أُخرى وعّوا الأفراد والجماعات بقيمة الحياة وحقوق الإنسان، ودفعوا المجتمع إلى أن يتحرّك بشكل نهضات وثورات وغيّروا بذلك وجه العالم.
وفي رأيي أنّ هناك - عدا الأسباب التاريخية - سبباً نفسياً وموضعياً كان له دخل أيضاً في تخلّي المشرق الإسلامي عن الاهتمام بمسألة الحقوق العقلية التي وضع هو أُسسها الأُولى، وذلك التفاوت النفسي والمعنوي بين الفرد الشرقي والفرد الغربي. فالشرق يميل إلى الأخلاق، أمّا الغرب فيميل إلى الحقوق... الشرق يعشق الأخلاق والغرب يعشق الحقوق... الشرقي بحكم طبيعته الشرقية يرى إنسانيته بالعطف والعفو وحب أبناء جنسه وبشهامته. لكن الغربي يرى الإنسانية في أن يعرف حقوقه ويدافع عنها وألاّ يدع أحداً يسلبها منه. إنّ البشرية بحاجة إلى الأخلاق كما هي بحاجة إلى الحقوق، فالإنسانية ترتبط بالحقوق كما ترتبط بالأخلاق، وليس أي من الحقوق أو الأخلاق معياراً وحيداً للإنسانية.
الدين الإسلامي المقدّس كان ولا يزال يملك هذه الميزة وهي (الاهتمام بالحقوق والأخلاق معاً). فكما أنّ العفو والإخلاص والخير تُعدّ أموراً أخلاقية مقدّسة في الإسلام، كذلك معرفة الحقوق والدفاع عنها
تُعدّ مقدّسة وإنسانية، ولهذا الموضوع شرح مفصّل ليس الآن وقت عرضه.
لكنّ الروح الشرقية الخاصة قد عملت كذلك، فأخذ الشرقي بادئ الأمر من الإسلام حقوقه وأخلاقه، ثم بالتدريج ترك الحقوق واهتمّ فقط بالأخلاق.
الغرض الآن أنّ المسألة التي نواجهها هي مسألة فلسفية وعقلية، مسألة استدلال وبرهان، وهي ترتبط بحقيقة العدالة وطبيعة الحقوق؛ فالعدالة والحق كانا موجودين من قبل أن يُشرّع قانون في الدنيا، ولا يمكن تغيير ماهيّة العدل والحق بوضع قانون بشرى.
يقول منتسكيو: (قبل أن يضع الإنسان القوانين، كانت هناك روابط عادلة تحكم بين الموجودات، ثم أصبح وجود هذه الروابط سبباً لوضع القوانين. فإذا افترضنا الآن أنّه لم يكن هناك أي شيء عادلاً كان أو ظالماً، عدا القوانين البدائية، فذلك يشبه قول مَن يفترض أنّ أقطار دائرةٍ لم يرسمها بعد، غير متساوية).
ويقول هربرت سبنسر: (تمتزج العدالة بشيءٍ آخر غير الإحساسات ألا وهي الحقوق الطبيعية للأفراد، ومن أجل أن يكون للعدالة وجود خارجي، يجب على الأفراد أن يحترموا الحقوق والامتيازات الطبيعية).
وهكذا نجد أنّ كثيراً من حكماء أوروبا يتبنّون هذه الفكرة، وأنّ
حقوق الإنسان التي صيغت بعنوان بيانات ومواد إنّما كان منبعها فرضية الحقوق الطبيعية التي ذكرنا. وبتعبير آخر: إنّ لائحة حقوق الإنسان لم تكن تعني - في حقيقتها - غير فرضية الحقوق الطبيعية والفطرية ليس إلاّ.
وكما وجدنا في علماء ومفكري أوروبا من أمثال منتسكيو وسبنسر وغيرهما ممّن عرفتم رأيهم في العدل حيث جاء مطابقاً لعقيدة المتكلّمين المسلمين في الحسن والقبح العقليين ومبدأ العدل، كذلك وجد بين علماء الإسلام أفراد أنكروا مسألة الحقوق الذاتية واعتبروا العدالة أمراً وضعياً.
لائحة حقوق الإنسان فلسفة وليست قانوناً
من المضحك ما يقال من أنّ مواد لائحة حقوق الإنسان قد صادق عليها المجلسان، ولما كان حق المساواة بين المرأة والرجل ضمن مواد اللائحة، إذاً يجب أن يتمتّع كل منهما بحقوق متساوية بموجب هذا القانون.
ولكن متى كانت لائحة حقوق الإنسان داخلة ضمن صلاحية المجلسين كي يصادقا عليها أو يرفضاها؟
فمحتويات اللائحة ليس عقوداً أو اتفاقيات كي يمكن للسلطات التشريعية في مختلف البلدان أن تصادق عليها أو لا تصادق.
لائحة حقوق الإنسان وضعت موضع البحث والنقاش: الحقوق
الذاتية للإنسان والتي هي بطبعها غير قابلة للسلب والإسقاط، وطرحت - كقانون - حقوقاً للإنسان ادعت أنّها شرط لإنسانية الإنسان، وأنّ يد القدرة هي التي منحت الإنسان هذه الحقوق الأخيرة. أي إنّ لائحة حقوق الإنسان افترضت للإنسان حقوقاً ادعت أنّ القوّة الخالقة التي منحت الإنسان العقل والإرادة والشرف الإنساني هي التي منحته هذه الحقوق.
وليس من حق الناس أن يضعوا لأنفسهم ما وضعته ومنحته إيّاهم لائحة حقوق الإنسان ولا أن يسلبوها أنفسهم.
إذن فماذا تعني مصادقة المجلسين والسلطة التشريعية عليها؟
إنّ لائحة حقوق الإنسان فلسفة وليست قانوناً. فيجب أن يقرّها الفلاسفة النوّاب؛ إذ لا يمكن للمجلسين عن طريق التصويت والقيام والقعود أن يضعا للشعب فلسفةً ومنطقاً. ولو كان الأمر كذلك لتوجّب أن تعرض نظرية اينشتاين الفلسفية (النسبية) على المجلس ليصادق النوّاب عليها، وكذا الحال بالنسبة لفرضية وجود الحياة على الكواكب الأُخرى. إنّ القانون الطبيعي لا يمكن المصادقة عليه أو رفضه بوساطة القوانين الوضعية، ومثل ذلك كمثل قولنا: إنّ المجلسين قد صادقا على أن الكمثرى إذا طُعّمت بالتفاح كان الناتج جيداً وإذا طُعّمت بالتوت لم تكن كذلك!
مثل هذه اللائحة حين تصدر من قبل مجموعة من المفكّرين
والفلاسفة فإنّ الأمم يجب أن تضعها بين أيدي فلاسفتها وأخصائيي الحقوق لديها. فإذا وافق عليها فلاسفة ومفكّروا تلك الأُمّة، كان على أفرادها أن يتعاملوا معها على أنّها حقائق فوق القانون. وأصبح لزاماً على السلطة التشريعية أن لا تصادق على قانون يعارضها.
أمّا الأُمم الأُخرى، فما لم يثبت لديها وجود مثل هذه الحقوق في الطبيعة، لا تكون ملزمة بمراعاتها. ومن ناحية أُخرى. فإنّ هذه المسائل ليست مسائل تجريبية ولا مختبرية لكي تحتاج إلى مختبرات وأجهزة لتدقيقها ممّا يتيّسر للأوروبيين ولا يتيسّر لسواهم. إنّها ليست تفجيراً ذرّيّاً كي يقتصر إنجازه والإحاطة به على أفراد معيّنين دون غيرهم، بل هي الفلسفة والمنطق، وأدواتها العقل وقوّة الاستدلال.
ولو افترضنا أنّ هناك بعض الأُمم لا تجد في نفسها الكفاية والخبرة في الأمور الفلسفية، فتقوم بتقليد غيرها في مسائل الفلسفة، إلاّ أنّنا - نحن الإيرانيين - قد أثبتنا جدارة فائقة منذ القدم في البحوث المنطقية والفلسفية، فلم نقلّد غيرنا فيها حتى اليوم؟
العجيب أنّ علماء الإسلام حين كان يعرض أساس مبدأ العدالة والحقوق الذاتية للبشر، كانوا يمنحونه أهميّة كبرى على أسس أنّ هذا هو حكم الشرع من دون: كيف؟ ولماذا؟ قاعدة تطابق العقل والشرع. أي أنّ العدالة والحقوق الذاتية للإنسان تحتاج إلى تأييد شرعي. أمّا اليوم فقد وصل بنا الحال إلى أن تحتاج هذه الأمور إلى مصادقة النوّاب
لكي تحظى بتأييدنا وقبولنا.
الفلسفة لا تثبت بالقسيمة
والمضحك أكثر هو أنّنا حين نريد البحث في الحقوق الإنسانية للمرأة، يتوجّب علينا استطلاع آراء الأولاد والبنات الشابّات، فنطبع القسائم ونوزّعها عليهم، وبعد ملئها من قِبَلهم ودراستها نتعرّف على حقوق الإنسان. وفيما إذا كانت حقوق المرأة والرجل - كأُناس - من نوع واحد أو نوعين. وعلى كل حال، فإنّنا سنبحث مسألة الحقوق الإنسانية للمرأة بشكل علمي وفلسفي، وعلى أساس الحقوق الذاتية للبشر كي نرى ما إذا كانت المبادئ التي اقتضت أن تكون للإنسان عموماً حقوق طبيعية من قِبَل خالقه، توجب أن تكون المرأة والرجل على حال واحدة متشابهة بالنسبة لهذه الحقوق أم لا؟ لذا نرجو من علماء ومفكّري وحقوقي القطر، والذين هم المرجع الوحيد ذو الصلاحية في النظر في هذه الأُمور أن يحقّقوا بعين النقد والانتقاد فيما نذكر الآن. وسأكون مسروراً إذا أعربوا عن رأيهم - في الرفض أو القبول - معزّزاً بالأدلّة. ولبحث هذا المطلب يجب أوّلاً أن نبحث في أساس الحقوق الإنسانية عموماً، ثم في خصوص حقوق المرأة والرجل بعد ذلك. ولا أرى بأساً - قبل كل ذلك - أن أشير باختصار إلى نهضات المطالبين بالحقوق في القرون الأخيرة، والتي انتهت بنظرية حق المساواة بين الرجل والمرأة.
نظرة إلى تاريخ حقوق المرأة في أوروبا
بدأت في أوروبا منذ القرن السابع عشر همسات تتناول حقوق الإنسان، ثم سعى الكتّاب والمفكرون - في القرنين السابع عشر والثامن عشر - لنشر آرائهم حول حقوق الإنسان الطبيعية والفطرية غير القابلة للسلب، بين الناس سعياً حثيثاً وعجيباً، وكان من بين هؤلاء المفكّرين والكتّاب جان جاك روسو، وفولتير ومنتسكيو. وكانت أول نتيجة عملية لسعي هؤلاء الكتّاب أن حصل في انكلترا أخذ ورد شديدان بين الحكومة والشعب، وما أن حلّ عام 1688. حتى حصل الشعب الانكليزي على جزء من حقوقه الاجتماعية والسياسية بعد إعداد بيان بهذه الحقوق وموافقة الحكومة عليها(1) .
ومن النتائج العملية البارزة لانتشار هذه الأفكار خلال حروب الاستقلال التي شنّها الأمريكان ضد انكلترا أنّ ثلاث عشرة مستعمرة انكليزية في أمريكا الشمالية تمرّدت نتيجة الضغوط عليها من قِبل الانكليز وواصلت كفاحها حتى نالت استقلالها.
وفي سنة 1776م عُقد في فيلادلفيا مؤتمر أعلن حق كل الشعوب في الاستقلال وتقرير المصير، ثم نُشر بيان في هذا المجال ورد في مقدّمته: (إنّ جميع أفراد البشر متساوون في الخلقة، وقد منح الخالق كل
____________________
(1) ترجمة تاريخ آلبرماله، ج4، ص336.
فرد حقوقاً ثابتة لا تتغيّر مثل حق الحرية، وإنّ الغاية من تشكيل الحكومات حفظ الحقوق المذكورة، وإنّ قوّة الحكومات ونفوذ كلمتها منوطان برضى الشعب)(1) .
أمّا ما اشتهر في العالم باسم لائحة حقوق الإنسان فذلك ما أعلن بعد الثورة الفرنسية الكبرى. وهذه اللائحة عبارة عن مجموعة من المبادئ العامّة في بداية القانون الأساسي لفرنسا، وتعتبر جزءاً لا يتجزّأ من هذا القانون. وتشتمل على مقدّمة وسبع عشرة مادّة.
وأوّل مادّة في هذا القانون هي: (إن أفراد البشر وُلدوا أحراراً ويظلّون مدى الحياة أحراراً ومتساوين في الحقوق...).
وفي القرن التاسع عشر ظهرت أفكار جديدة في مجال حقوق الإنسان في المجالات الاقتصادية والسياسية، انتهت بظهور الاشتراكية ووجوب حصر العائدات بالطبقات الكادحة، وانتقال الحكم من الرأسمالية إلى يد الطبقة العاملة.
وحتى أوائل القرن العشرين، كان كل ما طرح وبحث في مجال حقوق الإنسان، هو ممّا يتعلّق بحقوق الشعوب في مقابل الحكومات أو حقوق الطبقات الكادحة في مقابل أرباب العمل.
وفي القرن العشرين ظهرت لأوّل مرّة مسألة (حقوق المرأة) في
____________________
(1) ترجمة تاريخ آلبرماله، ج5، ص234.
مقابل حقوق الرجل، واعترفت انكلترا لأوّل مرّة في أوائل القرن العشرين بتساوي حقوق المرأة والرجل، علماً بأنّها تُعد أقدم دولة ديمقراطية. أمّا الولايات المتحدة الأمريكية التي اعترفت بالحقوق الإنسانية عند إعلان استقلالها في القرن الثامن عشر فقد صادقت عام 1920م على قانون المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق السياسية، وفي القرن العشرين أقرّت فرنسا بهذا الأمر.
وعلى كل حال، ففي القرن العشرين، ظهرت في جميع أنحاء العالم مجاميع كثيرة تدعو إلى إجراء تحوّل عميق في العلاقات بين الرجل والمرأة من ناحية الحقوق والواجبات. وفي نظر هؤلاء: أنّ جميع التحوّلات التي حصلت في علاقة الشعوب بالحكومات وعلاقة الكادحين بأرباب العمل، لا تضمن تأمين العدالة الاجتماعية مادامت لم تتناول العلاقات الحقوقية بين الرجل والمرأة.
ولهذا - ولأوّل مرة في العالم - جاء في مقدمة البيان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الأُمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية عام 1948م، ما يلي: (لما كانت شعوب الأُمم المتحدة قد اعترفت بحقوق الإنسان وقيمة الفرد الإنساني وتساوي حقوق الرجل والمرأة...).
ولما ظهرت الثورة الصناعية في القرنين التاسع عشر والعشرين وما رافقها من تحوّلات ووقع الحيف على العمال - وخصوصاً النساء -
أصبح موضوع حقوق المرأة أكثر إلحاحاً، فقد كتب (آلبرماله) في كتابه التاريخي المعروف(1) قائلاً:
(حين كانت الحكومات لا تهتم بأحوال العمّال ولا تلقي بالاً إلى ما كانوا يلقونه من معاملة سيّئة من قِبل أرباب العمل، كان أصحاب المعامل يستخدمون النساء والأطفال القاصرين بأجور زهيدة، ولما كانت ساعات العمل كثيرة، فقد كان هؤلاء يقعون فريسة الأمراض المختلفة ويموتون وهم في سن الشباب).
كان هذا استعراضاً سريعاً لنهضة حقوق الإنسان في أوروبا.
وكما نعلم فإنّ جميع مواد لائحة حقوق الإنسان التي كانت جديدة على الأوروبيين، كان الإسلام قد طرحها قبل أربعة عشر قرناً، وقد كتب عن ذلك بعض علماء العرب والإيرانيين مقارنين بين الاثنتين في كتب خاصة. وبالطبع، فهناك اختلافات بين بعض ما ورد في اللائحة، وما طرحه الإسلام. وهي بحدّ ذاتها مجال بحث ممتع. ومن ضمن هذه الاختلافات مسألة حقوق المرأة والرجل التي يطرح فيها الإسلام مبدأ المساواة ويرفض مبدأ التشابه.
الكرامة والحقوق الإنسانية
(لما كان الإقرار بالكرامة الذاتية لكافّة أعضاء الأُسرة الإنسانية
____________________
(1) تاريخ آلبرماله، ج6، ص328.
والحقوق المتساوية غير القابلة للانتقال، يشكّل أساس الحرية والعدالة والسلام.
ولما كان عدم الاعتراف بحقوق الإنسان واحتقارها يؤدّي إلى ارتكاب الأعمال الوحشية نتيجة الضغوط النفسية للأفراد، فإنّ ظهور عالم يتمتّع فيه أفراد البشر بحرية الجهر بالعقيدة ويتخلّص فيه الناس من الخوف والفقر، يكون هو المثل الأعلى للبشرية.
ولما كانت حماية حقوق الإنسان يجب أن تتم بوساطة القانون لكي لا يضطر الناس إلى الثورة ضدّ الظلم والطغيان كعلاج أخير.
ولما كان من اللازم أساساً تشجيع تعميق العلاقات الودّيّة بين الشعوب.
ولما كانت شعوب الأُمم المتحدة قد أعلنت ضمن بيان إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان، وقيمة الفرد الإنسان، وتساوي حقوق الرجل والمرأة، وصمّمت بعزم راسخ على المساعدة في التقدّم الاجتماعي والعمل على تحقيق حياة أفضل في محيط أكثر حرّية.
لكلّ ما تقدّم وغيره:
فإنّ الجمعية العامّة تعلن عن اعتبار لائحة حقوق الإنسان شعاراً مشتركاً لجميع الشعوب والأُمم لكي يضعها جميع الأفراد وشخصيات المجتمع أمام أنظارهم ويجتهدوا عن طريق التربية والتعليم في تعميق احترام هذه الحقوق والحرّيات وتوسيعها ويتخذوا التدابير التدريجية
بين شعوبهم وبقيّة شعوب العالم من أجل إدراكها إدراكاً واقعياً، وتطبيقها على واقعهم وحياتهم سواء كان ذلك بين الدول الأعضاء أو بين الشعوب التي تقطن ضمن حدودها الإقليمية...).
العبارات الذهبية أعلاه كانت مقدّمة اللائحة العالمية لحقوق الإنسان، المقدّمة التي قيل بصددها: (إنّها أعظم إنجاز توصّل إليه البشر لحد الآن على طريق تأييد حقوق الإنسان).
وقد حسب حساب كل كلمة وجملة فيها، وكما ذكرنا فيما مرّ أنّها نتيجة أفكار فلاسفة الحرية والحقوقيين لعدّة قرون.
ملاحظات مهمّة حول مقدّمة لائحة حقوق الإنسان
نظمت هذه اللائحة في ثلاثين مادّة. وبغضّ النظر عن أنّ بعض الأمور قد تكرّرت في بعض المواد، أو على الأقل أنّ ذكر إحدى المسائل في مادة من المواد مغنٍ عن ذكر محتويات مواد أُخرى أو أنّ بعض مواد اللائحة يمكن تجزئتها إلى مواد متعدّدة، فهناك ملاحظات مهمّة على مقدّمة اللائحة نراها جديرة بالعرض:
1 - يتمتّع جميع الناس بمستوى واحد من الكرامة والاحترام والحقوق الذاتية غير القابلة للانتقال.
2 - الكرامة والاحترام والحقوق الذاتية للإنسان عامّة لجميع أفراد النوع الإنساني بدون فرق، يتساوى في ذلك الأبيض والأسود، والطويل والقصير، والمرأة والرجل، فكما أنّ بين أعضاء الأُسرة
الواحدة لا يمكن أن يدعي أحدهم أنّ جوهره أشرف وأكثر أصالة من باقي الأعضاء، فكذلك جميع أفراد البشر الذين هم أعضاء أُسرة أكبر وأعضاء جنس واحد متساوون من حيث الشرف، ولا يستطيع أيّ فردٍ منهم أن يدّعي أنّه أشرف من أيّ فردٍ آخر.
3 - أساس الحرية والسلام والعدالة أن يؤمن جميع الأفراد في قرارة أنفسهم بكرامة واحترام جميع الناس.
إنّ هذه اللائحة تود أن تقول: (إنّها اكتشفت علّة جميع المشكلات التي تقع بين أفراد البشر، إنّ سبب نشوب الحروب ووقوع الظلم والاعتداء والجرائم بين الأفراد والأقوام إنّما هو عدم الاعتراف بالكرامة والاحترام الذاتي للإنسان. فإنّ عدم اعتراف طرف بكرامة الطرف الآخر يضطرّ الأخير إلى الثورة والتمرّد، وهذا ما يعرِّض الأمن والسلام إلى الخطر.
4 - المثل الأعلى الذي يجب أن يسعى الجميع لبلوغه هو بناء عالم تسوده حرية الاعتقاد والأمن والرفاه المادي بشكل كامل، وينعدم فيه الخوف والفقر والإرهاب. وقد نظمت مواد اللائحة الثلاثون من أجل تحقيق المثل الأعلى.
5 - يجب أن يتربّى جميع الأفراد على الإيمان بالكرامة الذاتية للإنسان واحترام حقوقه غير القابلة للسلب والانتقال.
مكانة الإنسان واحترامه
لما كانت لائحة حقوق الإنسان قد وضعت على أساس من احترام الإنسانية والحرية والمساواة من أجل إحياء حقوق الإنسان، فهي محل احترام وتقدير كل إنسان شريف، ونحن شعوب الشرق قد كنا ننادي منذ قديم الزمان بضرورة احترام الإنسان وقيمته ومكانته، وفي الدين الإسلام - كما ذكرنا سابقاً - يتمتّع الإنسان وحقوق الإنسان والحرية والمساواة بأقصى درجات الاحترام. وإن كتّاب ومنظّمي هذه اللائحة وكذلك الفلاسفة الذين كانوا هم الملهمين الحقيقيين لهذه اللائحة هم محل احترامنا وتقديرنا. ولكن بما أنّ هذه اللائحة هي متن فلسفي كتب بيد إنسان لا بيد ملائكة، وهي من استنباط مجموعة من أفراد بني الإنسان، فمن حق أي فيلسوف إذاً أن ينقدها، وإذا وجد في بعض موادها أحياناً شيئاً من الضعف، أن يشير إليه.
هذه اللائحة ليست خالية من نقاط الضعف ولكنّنا لا نريد الآن أن نشير إلى نقاط الضعف بل إلى نقاط القوّة فيها.
تستند اللائحة إلى (مكانة الإنسان الذاتية)، والشرف والكرامة الذاتية للإنسان - في نظر اللائحة - يمتلك مجموعة من الحقوق والحريات نتيجة لامتلاكه لنوع خاص من الكرامة والشرف، ممّا تفتقده باقي الأحياء وتفقد معه هذه الحقوق والحريات. وهذه هي نقطة القوّة في اللائحة.
هبوط الإنسان في الفلسفات الغربية
هنا نقف وجهاً لوجه - مرة ثانية - مع مسألة فلسفية قديمة، هي قيمة الإنسان ومكانته وشرفه بالنسبة إلى باقي المخلوقات، وشخصيته اللائقة بالاحترام. ويجب الآن أن نتساءل عن ماهيّة الكرامة الذاتية للإنسان والتي كانت منشأ حقوق له ميّزته عن الحصان والبقرة والخروف والحمامة.
وهنا بالذات يبرز تناقض واضح بين أساس لائحة حقوق الإنسان من جهة، وبين قيمة الإنسان في فلسفة الغرب من جهةٍ أُخرى.
في فلسفة الغرب كان الإنسان - لسنوات - فاقد القيمة والاعتبار، وما كان يذكر في السابق في بلاد الشرق عن الإنسان ومكانته الممتازة، هو اليوم محل سخرية واحتقار أغلب الفلسفات الغربية.
فالإنسان في النظرة الغربية قد هبط إلى مستوى الماكنة، أما روحه وأصالته فهي محل إنكار هناك. والاعتقاد بـ (العلّة الغائية) والهدف من وجود الطبيعة يُعدّ اعتقاداً رجعيّاً.
في الغرب لا يمكن الحديث عن كون الإنسان أشرف المخلوقات؛ لأنّه في نظر الغربيين صار الاعتقاد بهذه الفكرة وبأنّ باقي المخلوقات متطفّلة على الإنسان ومسخّرة له ليس إلاّ أمراً ناشئاً عن العقيدة البطليموسية القديمة التي ضمنت - فيما ضمنت - فكرة مركزية الأرض ودوران الكواكب الأخرى حول الأرض، وتضمّنت شرحاً عن شكل
الأرض والكواكب الأُخرى، وبزوال هذه العقيدة، زالت كذلك فكرة كون الإنسان أشرف المخلوقات. ففي الغرب لم تكن هذه الفكرة إلاّ نتيجة إعجاب الإنسان بنفسه في الماضي، أمّا اليوم فقد أصبح متواضعاً لا يرى نفسه أكثر من قبضة من التراب - كبقية المخلوقات - بدأ من الأرض ويعود إليها وينتهي فيها.
والغربي اليوم - وبكل تواضع - لا يرى الروح جانباً من جوانب الإنسان ولا يعتقد ببقائها، ولا يرى في ذلك فرقاً بين الإنسان والنبات والحيوان. الغربي لا يرى فرقاً بين الفكر والنشاط الروحي من جهة وبين حرارة الفحم الحجري من جهة أخرى من ناحية الماهية والجوهر، فكلّها في نظره مظاهر للمادة والطاقة، وفي نظر الغرب أنّ الحياة ما هي إلاّ ميدان دامٍ يضم جميع الأحياء، ومن جملتها الإنسان حيث تجري معارك تنتهي يحكم الوجود خلالها مبدأ تنازع البقاء بين الأحياء ومن جملتها الإنسان. والإنسان في هذا الوجود يكافح بجد من أجل استمرار بقائه. وما العدالة والعمل الصالح والتعاون وحب الخير وسائر المفاهيم الأخلاقية الإنسانية إلاّ إفرازات مبدأ تنازع البقاء ابتكرها الإنسان لحفظ وجوده وبقائه.
والإنسان في نظر بعض الفلسفات الغربية ماكنة لا تحركها إلاّ المصالح الاقتصادية، أمّا الدين والأخلاق والفلسفة والعلم والأدب والفن فليست إلاّ واجهات بناء أساسه وسائل الإنتاج وتوزيع الثروة،
وكل ذلك مظاهر للجانب الاقتصادي من حياة الإنسان.
لا، بل إنّ هذه القيمة التي حدودها للإنسان أكثر من قدره في نظر القسم الآخر من الفلاسفة، فإنّ المحرّك والدافع الأساسي لنشاط الإنسان - في نظرهم - هو العامل الجنسي، وما الأخلاق والفلسفة والعلم والدين والفن إلاّ مظاهر لطيفة للعامل الجنسي في وجود الإنسان.
ولكن لا أدري فيما لو أنكرنا وجود الغاية والحكمة من الخلق، واعتقدنا أنّ الطبيعة تعمل بشكل أعمى، وفيما لو كان القانون الوحيد الذي يحكم حياة الأحياء هو تنازع البقاء وانتخاب الأصلح، وأنّ كل متغيّرات الطبيعة تحكمها المصادفة، وأنّ وجود وبقاء الإنسان ما هو إلاّ نتيجة تغيّرات صدفتية* وغير هادفة قد استمرّت بضع ملايين من السنين حيث كان أجداد الإنسان الحالي أليق بالحياة من باقي الأنواع ممّا أدّى إلى ظهور إنسان اليوم، وإذا اعتقدنا أنّ الإنسان نفسه ليس إلاّ نموذجاً من الماكينات التي تصنعها يداه، وإذا كان الاعتقاد بالروح والأصالة وبقاء الإنسان نوعاً من الإعجاب بالنفس والمبالغة في تعظيم الإنسان نفسه، وإذا كان الدافع الرئيس للبشر في جميع النشاطات هو الأمور الاقتصادية أو الجنس أو حب الظهور، وإذا كان الخير والشر - عموماً - مفاهيم نسبيّة، والإلهامات الفطرية والوجدانية حديث هذيان. وإذا كان النوع الإنساني عبداً للشهوات والأهواء ولا يذعن إلاّ للقوّة، وإذا وإذا...
____________________
* بالصدفة. [ الشبكة ].
فكيف إذاً نستطيع أن نتحدّث عن كرامة وشرف الإنسان وحقوقه غير القابلة للسلب وشخصيّته المحترمة ونعتبرها أساس جميع نشاطاته؟!
الغرب يقع في تناقض حول الإنسان
في الفلسفة الغريبة، أهينت - إلى أقصى حدٍّ ممكن - الكرامة الذاتية للإنسان وتدنّت مكانته إلى الحضيض؛ فالعالم الغربي، في مسألة خلق الإنسان وعوامل وجوده، والغاية من خلقه، ونسيج تركيبه ودوافعه وحوافزه ووجدانه وضميره، هبط إلى الدرجة التي وصفنا.
هذا من ناحية، وفي الوقت ذاته يصدر من ناحية أخرى لائحة مطوّلة ومفصّلة حول قيمة الإنسان وكرامته ومكانته وشرفه الذاتي وحقوقه المقدّسة غير القابلة للانتقال، ويدعو جميع أفراد البشر إلى الإيمان بها.
وكان على الغرب أن يعيد النظر في تقييمه للإنسان أولاً، ثم يصدر آنذاك لوائحه المفصّلة على أساس من الحقوق المقدّسة والفطرية للإنسان.
ولا أعتقد أنّ جميع فلاسفة الغرب ينظرون إلى الإنسان نفس النظرة، فإنّ كثيراً منهم لا تختلف نظرتهم إلى الإنسان في قليل أو كثير عن النظرة الشرقية، وأعتقد أنّ اتجاه الفكر الذي ساد أكثر الأوساط الغربية قد ترك أثره على شعوب العالم.
إنّ لائحة حقوق الإنسان يجب أن يصدرها مَن يرى في الإنسان شيئاً أكبر من تركيب مادي ميكانيكي، ولا يرى دوافع الإنسان محصورة في الأمور الحيوانية، ومَن يعتقد أنّ للإنسان شيئاً اسمه الوجدان.
لائحة حقوق الإنسان يجب أن يصدرها الشرق الذي يؤمن بمبدأ( إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ) (1) ويرى في الإنسان مظهراً من مظاهر الإلوهية، والذي ينادي بحقوق الناس يجبان يعتقد بالغاية من وجود الإنسان:( يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ) (2) .
ولائحة حقوق الإنسان اللائقة بالبشر تلك التي تستند إلى فلسفة تؤمن بوجود حب الخير في طبيعة الإنسان على أساس:( وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ) (3) .
لائحة حقوق الإنسان يجب ان يصدرها من يحسن الظن بطبيعة الإنسان ويراها أكمل وأحسن الطبائع على أساس( لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ) (4) .
____________________
(1) سورة البقرة، الآية 30.
(2) سورة الانشقاق، الآية 6.
(3) سورة الشمس، الآيات 7 - 8.
(4) سورة التين، الآية 4.
وأمّا ما يلاءم نظرة الغرب إلى الإنسان فليس لائحة حقوق الإنسان، بل يلاءمها وينسجم معها ما يقوم به الغرب فعلاً من تصرّفات ومواقف تجاه الإنسان من اغتيال العواطف الإنسانية والاستخفاف بامتيازات البشر، وتفضيل رأس المال على الإنسان، وتقديم المال على الفرد الإنساني، وعبادة الآلة، وتأليه الثروة، واستغلال الإنسان، والتحكّم اللامحدود للرأسمالية إلى الحد الذي حين يوصي مليونير بثروته من بعده إلى كلبه المحبوب يجد هذا الكلب من الاحترام فوق ما يجد الإنسان، ويتسابق الناس هناك إلى العمل في خدمة الكلب الثري بصفة خادم وسكرتير، ومدير مكتب، وينحنون أمامه تعظيماً واحتراماً!
الغرب ينسى نفسه وربّه
إنّ أساس مشكلة المجتمع الإنساني اليوم هو أنّ الإنسان - بتعبير القرآن - قد نسي نفسه ونسي ربّه، والنقطة المهمّة في ذلك أنّه احتقر (ذاته)، فأهمل تربية باطنه، وأغفل التوجّه إلى ضميره، وحجّم وجوده كليّاً بعالم الحسّ والمادّة، فلم يعد يرى من غاية لوجوده سوى تذوّق المادّيات ولم يعد يرى وجوده إلاّ عبثاً في عبث. فأنكر ذاته وفقد روحه. وأكثر مشاكل البشرية اليوم ناشئة من هذا النوع من التفكير الذي يكاد تقريباً - وللأسف - يسيطر على العالم ويقضي فجأة على وجوده قضاءً تامّاً.
هذا اللون من التفكير أدّى إلى أنّ المدنية كلّما اتسعت وتعمّقت،
ازداد إحساس المتمدّن بالحقارة، وصار الإنسان الحقيقي أثراً تاريخياً يبحث عنه في الماضي ولا وجود له في الحاضر. وتستطيع عجلة الحضارة العظيمة اليوم أن تصنع كل عظيم من الآلات إلاّ الإنسان فإنّها لا تقدر على صنعه وصياغته.
يقول غاندي: (استحق الإنسان الغربي لقلب ملك الأرض لأنّه يسيطر على جميع الإمكانيات والمواهب الأرضية. إنّه يستطيع أن يقوم بأعمال على الأرض تراها الشعوب الأخرى من اختصاص الله وحده. لكنّ الإنسان الغربي عاجز عن شيء واحد ذلك هو التأمّل في باطنه، وهذا الموضوع وحده كافٍ لإثبات زيف أنوار التمدّن الجديد.
فالتمدّن الغربي يدعو الغربيين إلى الخمر والانغماس في الأعمال الجنسية من أجل أن ينسى الإنسان الغربي ذاته بدلاً من البحث عنها.
والقدرة العلمية للإنسان الغربي في مجال اكتشاف واختراع الأسلحة والمعدّات الحربية ما هي إلا مظهر للهروب من الذات، وليست مظهراً من مظاهر السيطرة على الذات نفسها. إنّ مظهر الخوف من الوحدة والصمت، واستخدام المال قد أعجز الإنسان الغربي عن سماع نداء ضميره وهذا هو الهدف من نشاطاته المستمرّة. إنّ الذي دفعه إلى السيطرة على أنحاء العالم هو عجزه عن حكم ذاته، وهذا ما يدفعه إلى نشر الفساد والاضطراب في كل أرجاء الدنيا... وماذا ينفع الإنسان فتح العالم وهو قد خسر روحه... والغربيون الذين أمرهم الإنجيل أن يكونوا
مبشّرين بالحق والحب والسلام في العالم، توجّهوا إلى كل صوب يبحثون فيه عن الذهب والعبيد والمنافع الشخصية، وبدلاً من أن يسيحوا طلباً للعدل والتسامح في بلاد الله طبقاً لتعاليم الإنجيل، نجدهم يستخدمون - للتحرّر من خطاياهم - الدين سلاحاً، وبدلاً من نشر كلام الله، نجدهم يصبّون القنابل على رؤوس الشعوب).
ولهذا السبب، نجد أنّ أوّل مَن ينقض لائحة حقوق الإنسان وأكثر مَن ينقضها هو الغرب نفسه، فالفلسفة التي يتبنّاها الغرب في واقعه العملي اليوم لا تسمح بغير نقض هذه اللائحة.
* * *
الفصل السادس
الأُسرة والأُسس الطبيعية
الأُسس الطبيعية لحقوق الأُسرة (1)
قلنا إنّ أساس وروح لائحة حقوق الإنسان هو أنّ للإنسان كرامة وشخصية ذاتية قابلة للاحترام، وأنّه قد مُنح في أصل خلقته مجموعة من الحقوق والحريات غير القابلة للسلب والانتقال بأيّ حالٍ من الأحوال.
وقلنا إنّ هذا الأساس والروح قد حظي بتأييد الإسلام والفلسفات الشرقية، وأنّ الذي لا ينسجم مع روح وأساس هذه اللائحة ويعتبرها واهية لا تستند إلى أساس، هي التفسيرات التي تطرحها المدارس الفلسفية في الغرب حول الإنسان ونسيج خلقه.
وبديهي أنّ المصدر الوحيد المخوّل في تعريف حقوق الإنسان والواقعية هو كتاب الخلق الثمين، فبالرجوع إلى صفحات وسطور هذه الكتاب العظيم، نطّلع على حقوق الإنسان الحقيقة وعلى حقوق المرأة والرجل تجاه بعضهما البعض.
والعجيب أنّ بعضاً من البسطاء، غير مستعدّين إطلاقاً للاعتراف بهذا المصدر العظيم. وفي نظر هؤلاء إنّ المصدر الوحيد المخوّل هو مجموعة من أفراد البشر الذين كانت لهم يد في تنظيم لائحة حقوق
الإنسان وهم اليوم يحكمون العالم كلّه. وهم يلتزمون عملياً ببنود هذه اللائحة، ولا يجرؤ الآخرون على الاعتراض عليهم. أمّا نحن فباسم حقوق الإنسان نفسها نعطي لأنفسنا حق الاعتراض ونعتبر جهاز الخلقة العظيم (العالم) - هذا الكتاب الإلهي المعبّر - مرجعاً صالحاً لنا في البين.
إنّني أعتذر مجدّداً للقرّاء المحترمين من ورود بعض الأُمور في هذه السلسلة من المقالات حيث ظهر فيها لون فلسفي جاف قد يسبّب لهم الملل، وقد حاولت قدر الإمكان عند طرح هذه المسائل أن أجتنب ذلك، إلاّ أنّ ارتباط قضايا حقوق المرأة ببعض المسائل الفلسفية الجافّة كانت من القوّة بحيث لا يمكن تجنّبها.
ترابط الحقوق الطبيعية وهدفيّة الطبيعة
إنّ الحقوق الطبيعية والفطرية - من وجهة نظرنا - ترجع إلى الاستعدادات التي أوجدتها القوّة الخالقة في الموجودات والتي تستثمرها في توجيه هذه الموجودات بهدفيّة وقصد نحو التكامل الذي تريده لها.
ففي مقابل كل استعداد طبيعي يوجد (حق طبيعي) ويحسب به سنداً طبيعياً فالإنسان - مثلاً - يملك حق التعليم والذهاب إلى المدرسة، أمّا الخروف فلا يملك هذا الحق، لماذا؟ لأنّ الاستعدادات لتحصيل العلم وبلوغ المراتب العلمية موجودة في بني الإنسان ومفقودة في الخروف.
والقدرة الخالقة قد أودعت سند هذا الحق في وجود الإنسان ولم
تودعه في وجود الخروف. وهذا يصدق على حق التفكير والتصويت وحرية الإرادة، ويُخيّل إلى البعض أنّ فرضية (الحقوق الطبيعية) وتميّز الإنسان - خلقة - بحقوق خاصة؛ ادعاء أجوف وأناني يجب أن يُطرد من الأذهان فلا فرق بين الإنسان وغير الإنسان في الحقوق.
كلاّ، وليس الأمر كذلك، فإنّ الاستعدادات الطبيعية تختلف، وأنّ القوّة الخلاّقة قد وضعت كل نوع من أنواع الموجودات في مدار خاص بها، وحصرت سعادة كل ذلك النوع في حركته ضمن مداره الطبيعي، وهذه القوّة لها هدف من وراء هذا العمل فهي لم تسلم هذه السندات بيد المخلوقات عبثاً ومصادفة.
إنّ أساس وجذر حقوق الأُسرة التي هي مجال بحثنا الآن - مثل باقي الحقوق الطبيعية - يجب أن يخضع للتدقيق. ومن الاستعدادات الطبيعية - للمرأة والرجل - التي أودعها الخالق فيهما نستطيع أن نفهم ما إذا كانت المرأة والرجل يملكان حقوقاً وواجبات متشابهة أو لا. ولا تنسوا أنّ مجال بحثنا الآن - كما قلنا في المقالات السابقة هو (تشابه حقوق) المرأة والرجل في الأسرة وليس (تساوي حقوقهما).
الحقوق الاجتماعية
يتمتّع أفراد بني الإنسان في مجال الحقوق الاجتماعية غير الأُسرية - أي في المجتمع الكبير خارج محيط الأسرة - بوضع متساوٍ ومتشابه، أي إنّ لكل منهم حقوقاً أوّلية طبيعية يتساوى فيها الجميع
تماماً. فللجميع حق الاستفادة من مواهبهم الطبيعية، وللجميع حق العمل وللجميع أن يشتركوا في سباق الحياة، وللجميع الحق في ترشيح أنفسهم لأيّ مقام اجتماعي شاءوا ولكل منهم أن يسلك للحصول على ذلك كل طريق مشروع، وللجميع الحق في إظهار استعداداتهم العلمية والعملية.
وبالطبع فإنّ نفس هذا التساوي في الحقوق الأوّلية الطبيعية سيجرهم بالتدريج إلى وضع غير متساوٍ في الحقوق المكتسبة، فهم جميعاً يملكون حقّاً على درجة واحدة في العمل والاشتراك في سباق الحياة، ولكن حين يصل الأمر إلى كيفيّة إنجاز الأعمال والاجتهاد في السباق، فإنّ الجميع لا يخرجون من المسابقة بدرجة واحدة من الإجادة والانجاز، ففيهم مَن هو أكثر استعداداً، وفيهم مَن هو أقلّ استعداداً، ومنهم النشيط الفعّال، ومنهم الكسول المتقاعس. والخلاصة: أنّ بعضهم أعلم وأكمل وأكثر تفنّناً وأكثر إنتاجاً وأليق من البعض الآخر، وهذا ممّا يؤدّي إلى حصولهم على حقوق مكتسبة غير متساوية، وإذا أردنا أن نساوي بينهم في الحقوق المكتسبة، كما تساووا في الحقوق الطبيعية الأوّلية، فلن يوسم تصرّفنا هذا بغير الظلم والعدوان.
ولننظر الآن لماذا كان جميع الأفراد يتمتّعون بقدرٍ متساوٍ ومتشابه من الحقوق الطبيعية الأوّلية في المجتمع؟
الجواب: قد ثبت من خلال مطالعة أحوال البشر، أنّ الأفراد لم يولد أيّ منهم رئيساً أو مرؤوساً بالطبع، ولم يولد أحد منهم عاملاً أو صانعاً أو
أُستاذاً أو معلّماً أو ضابطاً أو جندياً أو وزيراً، فليست هذه المهارات إلاّ مزايا وخصوصيات تُعد جزءاً من الحقوق المكتسبة، أي أنّ الأفراد يكتسبونها من المجتمع بفعل لياقتهم واستعدادهم ونشاطهم ومثابرتهم، ويقوم المجتمع بمنح هذه المناصب على أساس من قانون وضعي. ولا تختلف حياة الإنسان الاجتماعية عن حياة الحيوان الاجتماعية كالنحلة مثلاً إلاّ في هذا الجانب، فإنّ التشكيلات الحياتية لهذه الحيوانات طبيعية مائة في المائة، فقد وزّعت الطبيعة أعمالها ومراتبها وليس للحيوانات أي دخل في ذلك؛ فرئيسها رئيس بالطبع ومرؤوسها مرؤوس بالطبع، وفيها العامل وفيها المهندس وفيها المراقب، وكلّها قد خُلقت لتكون كذلك، أمّا الحياة الاجتماعية للإنسان فليست كذلك.
ولذا فإنّ بعض العلماء أنكر - بالمرّة - النظرية الفلسفية القديمة التي تقول: (الإنسان اجتماعي بالطبع) وافترض أن يكون المجتمع الإنساني تعاقدياً مائة في المائة.
حقوق الأُسرة
كان هذا في المجتمع غير الأُسري، فما هي الحال في المجتمع الأُسري؟ هل إنّ أفراد الأُسرة الواحدة متشابهون كذلك في الحقوق الطبيعية ومختلفون في الحقوق المكتسبة؟ أم أنّ المجتمع الأُسري (أي المجتمع المكوّن من: الزوجة والزوج، والأب والأم والأولاد، والإخوان والأخوات) يختلف عن المجتمع غير الأُسري في الحقوق الطبيعية
حيث يخضع أفراد الأُسرة لقانون طبيعي حقوقي خاص بهم؟
وهنا توجد فرضيتان:
الأُولى: أن تكون العلاقة بين الزوجين أو بين الأب وابنه، أو بين الأم وولدها؛ مثل باقي العلاقات الاجتماعية التي تحكم المؤسّسات الوطنية والحكومية، فلا تكون هذه العلاقة سبباً في اكتساب حقوق معيّنة وإنّما الخصائص المكتسبة هي التي تحدّد الرئيس والمرؤوس... المطيع والمطاع... الذي يكسب راتباً أكثر ممّن يكسب راتباً أقل. فلا تكون للزوجة باعتبارها زوجة، وللزوج باعتباره زوجاً، وللأب كأب، وللأم كأم، وللولد كولد، ميزة خاصة، وإنّما الخصائص المكتسبة هي التي تحدّد مركز كل منهم بالنسبة إلى الآخر.
إنّ فرضية (تشابه حقوق الزوجة والزوج في حقوق الأسرة) والتي سُمّيت خطأً بـ (المساواة في الحقوق) مبنيّة على أساس هذا الفرض. واستناداً إلى هذه الفرضية، فإنّ الزوجة والزوج بما يتمتّعان به من استعدادات واحتياجات متشابهة ووثائق حقوقية متشابهة منحتها إيّاهما الطبيعة فيجب أيضاً أن تنظّم حقوقهما الأُسرية على أساس التشابه والمماثلة.
الثانية: إنّ الحقوق الطبيعية الأوّلية لهؤلاء متباينة، فكون الزوج زوجاً يمنحه حقوقاً ويفرض عليه واجبات معيّنة والزوجة كزوجة لها حقوق وعليها واجبات أُخرى، وهذا لا يصدق على الأُبوّة والأُمومة
والبنوّة.
وعلى أيّ حالٍ فإنّ المجتمع الأُسري يختلف عن سائر الشركات والتعاونيات الاجتماعية الأُخرى.
وفرضية (عدم تشابه الحقوق الأُسرية بين المرأة والرجل) التي يقبلها الإسلام مبنيّة على هذا المبدأ.
والآن أي هاتين الفرضيتين اللتين ذكرنا صحيح؟ وعن أيّ طريقٍ يمكن لنا أن نثبت صحّتها؟
(2) الأُسس الطبيعية لحقوق الأُسرة
من أجل أن يتوصّل القرّاء المحترمون إلى استنتاج واضح؛ لابد أن يضعوا نصب أعينهم النقاط التي مرّت في الفصل السابق، قلنا:
1 - الحقوق الطبيعية مصدرها، أنّ للطبيعة أهدافاً، ولتحقيق هذه الأهداف أودعت في الموجودات استعدادات معيّنة ومنحتها على أساسها حقوقاً معيّنة.
2 - الإنسان - بحكم كونه إنساناً - يتمتّع بمجموعة من الحقوق الخاصة التي أُطلق عليها اسم حقوق الإنسان، بينما لا تتمتّع الحيوانات بمثل هذه الحقوق.
3 - كيفيّة تحديد الحقوق وشكلها مرتبط بمسألة الخلق.
فكل استعداد طبيعي هو سند لحيازة حق طبيعي.
4 - أفراد النوع الإنساني في المجتمع المدني يتمتّعون بحقوق طبيعية متساوية ومتشابهة، وما اختلافهم إلاّ في الحقوق المكتسبة التي تعتمد على العمل وإنجاز الواجب والمشاركة في سباق أداء الواجبات الاجتماعية.
5 - إنّ السبب في تمتّع أفراد النوع الإنساني في المجتمع المدني بحقوق طبيعية متساوية ومتشابهة هو أنّ المطالعة في طبيعة الإنسان توضّح أنّ أفراد الإنسان - بخلاف الحيوانات الاجتماعية كالنحل - ليس بينهم من ولد ليكون رئيساً أو مرؤوساً بالطبع... آمراً أو مأموراً بالطبع... عاملاً أو ربّ عمل بالطبع... ضابطاً أو جندياً بالطبع، فتشكيلات حياة الإنسان ليست طبيعية، أي أنّ الأعمال والمناصب والواجبات لم توزّع من قِبل الطبيعة.
6 - فرضية تشابه الحقوق الأُسرية للمرأة والرجل مبنيّة على أساس أنّ مجتمع الأُسرة يشبه المجتمع العام، فيكون لأفراد الأُسرة حقوق واحدة متشابه والمرأة والرجل يشاركان في حياة الأُسرة باستعدادات واحتياجات متشابهة ويمتلكان سندات طبيعية متشابهة، وأنّ قانون الخلقة لم يضع لهما تنظيمات طبيعية ولم يوزع بينهما الأعمال والمواقع.
أمّا فرضية عدم تشابه حقوق الأُسرة فتبنى على أساس أنّ مجتمع
الأُسرة هو غير المجتمع العام، والمرأة والرجل لا يشاركان في حياة الأُسرة باستعدادات واحتياجات، ولا يمتلكان سندات طبيعية متشابهة، وأنّ قانون الخلقة قد عيّن لهما مواقع وأدواراً مختلفة، ووضع كلاًّ منهما في مدار غير مدار الثاني. والآن لننظر أي الفرضيتين صحيحة؟ وكيف نثبت صحّتها وسلامتها؟
وبالمقياس الذي حدّدناه فيما سبق، ليس صعباً أن نحدّد أيّ الفرضيتين هي الصائبة. فإنّ ذلك يتعيّن بإعادة النظر في الاستعدادات والاحتياجات الطبيعية لكل من المرأة والرجل، أو ما يدعى بالسندات الطبيعية التي منحها قانون الخلقة للمرأة والرجل.
هل الحياة الأُسرية طبيعية أم وضعية؟
ذكرنا في المقالة السابقة أنّ هناك نظرتين حول (الحياة الاجتماعية للإنسان).
الأُولى: أنّها طبيعية، اصطلحوا على الإنسان أنّه (مدني بالطبع).
الثانية: على العكس من ذلك ترى أنّ الحياة الاجتماعية للإنسان وضعية اختارها الإنسان بنفسه نتيجة ضغط عوامل خارجية (لا من داخل الإنسان).
ولكن ماذا بالنسبة إلى الحياة الأُسرية؟ هل هنا أيضاً نظرتان؟ كلاّ، هنا لا توجد إلاّ نظرة واحدة. فالحياة الأُسرية للإنسان طبيعية مائة في المائة، أي أنّ الإنسان خلق بطبعه (منزلياً). ولو تردّدنا - فرضاً - في طبيعية
الحياة (المدنية) للإنسان، فلن نتردّد في طبيعية الحياة (المنزلية) أي الحياة الأُسرية. كذلك فهناك كثير من الحيوانات بالرغم من افتقادها الحياة الاجتماعية الطبيعية، بل الحياة الاجتماعية كليّاً، فإنّها تعيش حياة زوجية طبيعية كالحمام وبعض الحشرات التي تعيش أزواجاً.
إنّ الحياة الأُسرية تختلف عن الحياة الاجتماعية، فإنّ في الطبيعة تدابير مهيّأة من أجل دفع الإنسان وبعض الحيوانات بشكل طبيعي باتجاه الحياة العائلية وتشكيل المؤسّسة العائلية وإنجاب الأطفال.
ولم يثبت حتى الآن، وجود عصر من عصور التاريخ لم يعش فيه الإنسان الحياة العائلية أي أن تعيش المرأة والرجل فيه منفصلين أو تكون فيه العلاقة الجنسية عامة مشتركة بين الأفراد. وحتى حياة القبائل المتوحشة الموجودة في العصر الحاضر - والتي هي نموذج لحياة الإنسان القديم - لم تكن كذلك.
وقد اتخذت حياة الإنسان القديم في بعض الأحيان شكل (حكومة الأم) وفي أحيان أُخرى شكل (حكومة الأب).
فرضية المراحل الأربع
في مسألة الملكية نالت هذه الحقيقة قبول الجميع في أنّها ابتدأت بشكل مشترك، ثم اختصّت بالأفراد بعد ذلك. ولكن في الناحية الجنسية لم يحصل مثل هذا أبداً. والسبب في الملكية المشتركة في حياة البشر الأُولى هو كون المجتمع آنذاك قبلياً، وتلعب العواطف والعلاقات
الأُسرية دورها في حياة القبيلة ممّا يؤدّي إلى بقاء الملكية مشاعة بينهم. ولنفرض أنّه لم تكن في مراحل البشرية الأُولى قوانين تحدّد مسؤولية المرأة والرجل تجاه بعضهما البعض، إنّما الإحساسات الطبيعية هي التي كانت تحدّد لهما واجبات وحقوقاً، ولم تكن الحياة الجنسية بدون قيد أو شرط. كذلك الحال بالنسبة للحيوانات التي تعيش بشكل زوجي، صحيح أنّ قانوناً اجتماعياً أو وضعياً لم يكن يحكم علاقاتها ولكنّها كانت تراعي حقوقاً وواجبات بحكم قانون طبيعي، كما أنّ حياتها الجنسية لم تكن بدون قيد أو شرط.
تقول السيدة منوجهريان في مقدّمة كتاب (انتقاد بر قوانين أساسي ومدني إيران) أيّ نقدٍ لقوانين إيران الأساسية والمدنية: (من وجهة نظر علم الاجتماع، تقسم حياة المرأة والرجل في مختلف بقاع المعمورة إلى أربع مراحل تاريخية:
1 - المرحلة الطبيعية.
2 - مرحلة سلطة الرجل.
3 - مرحلة اعتراض المرأة.
4 - مرحلة تساوي حقوق المرأة والرجل.
في المرحلة الأُولى، كانت المرأة والرجل يعيشان حياة جنسية مختلطة بدون قيد أو شرط).
إنّ علم الاجتماع يرفض هذا القول وأقصى ما يقبله هو أنّ بعض
القبائل المتوحّشة كان يحصل فيها أحياناً أن يتزوج عدد من الإخوة من الأخوات، ولكنّ جميع الإخوة يكونون أزواجاً لجميع الأخوات ويكون الأولاد أولاداً للجميع. أو أنّ الأبناء والبنات لا يتقيدون بحدود قبل الزواج وإنّما بعد الزواج. وإذا حصل أحياناً في بعض القبائل المتوحّشة وضع جنسي أعم من هذا، أو ما يصطلح عليه بوضع (المرأة المشتركة)، فإنّما يُعدّ ذلك حالة استثنائية وانحرافاً عن الوضع الطبيعي العام.
يقول ويل ديورانت في الجزء الأوّل من تاريخ الحضارة صفحة 57: (الزواج هو أحد اختراعات أجدادنا الحيوانات، ففي بعض الطيور يكتفي كل طائر بزوجته فقط، وفي الغوريلا والاورانغوتان - من القرود - تستمر العلاقة الزوجية بين الذكر والأُنثى إلى نهاية مرحلة تربية طفلهما، وهذه العلاقة شبيهة من نواح كثيرة بعلاقة المرأة والرجل وكلّما حاولت الأُنثى الاقتراب من ذكر آخر تعرّضت لتأنيب شديد من قِبَل الذكر الأوّل).
ويتحدث د وكر سبيني عن قرود اورانغوتان بورنيو قائلاً: (إنّها تعيش بشكل أُسر تتكون من الذكر والأُنثى والأولاد).
ويكتب الدكتور سافاج عن الغوريلا: (عادتهم أن يجلس الأب والأم تحت إحدى الأشجار وينهمكان في تناول الفاكهة وفي الثرثرة، بينما أولادهما من حولهما منتشرون فوق الأشجار. إنّ الزواج ظهر على
صفحات التاريخ قبل ظهور الإنسان. وما أقل المجتمعات التي لم تمارس مسألة الزواج، ولكنّ الباحث كان يمكن أن يلتقي بعدّة مجتمعات على النحو الأخير).
المقصود أنّ المشاعر العائلية عند الإنسان أمر طبيعي وغريزي، وليست نتيجة السعادة والتمدّن، كما أنّ كثيراً من الحيوانات تمتلك - بصورة طبيعية وغريزية - المشاعر العائلية.
وعلى هذا، فلم تمر بالبشرية أبداً مرحلة كان الجنسان يتعايشان فيها بشكل تام دون أي قيد ولا شرط ولا التزام، ولو كان التزاماً طبيعياً. ومثل هذه المرحلة المفترضة تماثل الاشتراك الجنسي الذي لا يدّعيه حتى مدّعو الاشتراكية المالية في المراحل الأُولى.
فرضية المراحل الأربع في علاقات المرأة والرجل ليست إلاّ تقليداً لفرضية المراحل الأربع التي يؤمن بها الاشتراكيون حول الملكية إذ يقولون: (إنّ البشرية فيما يخص الملكية قد مرّت بأربع مراحل: مرحلة الاشتراكية البدائية، ومرحلة الإقطاع، ومرحلة الرأسمالية، ومرحلة الاشتراكية والشيوعية التي تُعدّ عودة إلى الاشتراكية البدائية ولكن على مستوى أعلى).
والطريف أنّ السيدة منوجهريان أطلقت اسم المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل على المرحلة الرابعة من علاقة المرأة بالرجل؛ وبذلك تكون قد أعرضت عن تقليد الاشتراكيين إذ لم تطلق عليها اسم العودة
إلى الاشتراكية البدائية. ولكنّها مع ذلك تدرك التشابه بين المرحلة الرابعة والمرحلة الأُولى فتقول صراحة: (وفي المرحلة الرابعة - التي تشبه كثيراً المرحلة الأُولى - تعيش المرأة والرجل سوية دون أن يكون لأيٍّ منهما أيّة سلطة على الآخر).
ولم أستطع لحد الآن أن أفهم غرضها من عبارة (تشبه كثيراً) فإذا كان قصدها فقط عدم تسلّط الرجل وتساوي التزامات وظروف الطرفين في مقابل كل منهما، فهذا ليس شبهاً بين المرحلة الرابعة والمرحلة الأُولى، والتي تقول هي إنّها لم يكن فيها أي التزام أو قيد شرط، وإنّ حياة المرأة والرجل كانت فاقدة للصورة الأُسرية. أمّا إذا كان ما تقصده بالتشابه هو أنّ القيود والالتزامات تختفي تدريجياً في المرحلة الرابعة ممّا يؤدّي إلى اختفاء الأسرة في النهاية وشيوع الاشتراكية الجنسية، فيصبح واضحاً أنّ ما تعنيه بـ (تساوي الحقوق) - الذي تتبنّاه هي بشكل جدّي - شيء غير ما يعنيه باقي أنصار تساوي الحقوق والذي يرونه في بعض الأحيان شيئاً مختفياً.
والآن لنتّجه إلى البحث في طبيعة الحقوق الأُسرية للمرأة والرجل، وفي هذا المجال لابد أن نتاول شيئين:
الأول: هل يختلف الرجل عن المرأة من الناحية الطبيعية أم لا؟ وبتعبيرٍ آخر هل أنّ الاختلاف بينهما هو فقط من حيث طبيعة الجهاز التناسلي؟ أم أن بينهما فروقاً أعمق؟
الثاني: إنّه إذا كانت هناك اختلافات وفروق بينهما فهل أنّها من قبيل الفروق التي تؤثّر في تحديد الحقوق والواجبات، أم أنّها من نوع فروق اللون والعنصر التي ليست لها علاقة بطبيعة حقوق الإنسان؟
المرأة في الطبيعة
في الجانب الأوّل لا أظن أنّ هناك خلافاً بين اثنين، فكل مَن له أدنى اطلاع في هذا الجانب، يعلم أنّ الفروق بين المرأة والرجل لا تقتصر على الجهاز التناسلي فقط، إنّما الخلاف في أنّ هذه الفروق هل تتدخّل في تحديد الحقوق والواجبات لكل منهما أم لا؟
وقد بيّن علماء ومحقّقو أوروبا هذه الفروق بصورة وافية، والتدقيق في البحوث الحياتية والنفسية والاجتماعية التي قدّمها هؤلاء العلماء لا يدع أدنى مجال للشك في هذا الأمر. أمّا الشيء الذي لم يحز إلاّ على قليل من اهتمام هؤلاء العلماء هو كون هذه الفروق مؤثّرة في تحديد الحقوق والواجبات الأُسرية، وأنّها تضع المرأة والرجل في مواقع متباينة.
ويعترف الكسيس كارل - الفيزيولوجي والجرّاح وعالم الحياة الفرنسي المعروف، والذي حاز على شهرة عالمية - في كتابه القيّم (الإنسان ذلك المجهول)(1) بكلا القسمين. أي إنّه يقول إنّ المرأة
____________________
(1) بالفارسية: (إنسان موجود ناشناخته).
والرجل مختلفان من حيث الخلقة، وأنّ هذه الاختلافات الخلقية تقتضي أن يتفاوتا في الواجبات والحقوق.
إنّه يذكر في فصل تحت عنوان (النشاطات الجنسية وإنتاج المثل)(1) ما يلي: (للخصيتين والمبيضين أعمال متشعّبة، إذ إنّها تقوم بإنتاج الخلايا الذكرية أو الأنثوية أوّلاً والتي بتزاوجها يتكوّن إنسان جديد، وفي نفس الوقت تقوم بإفراز مواد داخل الدم تعيّن الخصائص الجنسية للرجل والمرأة في الأنسجة والأعضاء والمشاعر، كما تقوّي سائر الفعاليات البدنية. فإفراز الخصيتين يوجد الشجاعة والغضب والنشاط والخشونة في الرجل، وهي ذاتها الخصائص التي تميّز الثور المصارع عن ثور الحراثة، وأمّا المبيض فيترك آثاره الأنثوية الخاصة كذلك على المرأة).
(... إنّ الاختلاف بين المرأة والرجل لا يرتبط فقط بشكل الأجهزة التناسلية، ووجود الرحم عند المرأة والحمل والولادة، ونمط التعليم الخاص، وإنّما هو نتيجة لسبب أعمق ناشئ من أثر المواد الكيميائية التي تفرزها الغدد التناسلية في الدم).
(وبسبب عدم استيعاب مؤيّدي النهضة النسائية لهذه النقطة الرئيسة والمهمّة، فقد تصوّروا أنّ كلا الجنسين يمكن أن يتلقّيا تعليماً وتربية
____________________
(1) نفس المصدر السابق، ط3، ص100.
واحدة ويأخذا على عاتقهما مسؤوليات وصلاحيات وأعمال واحدة. فالمرأة تختلف في الحقيقة عن الرجل في جوانب كثيرة. فكل خلية من خلايا جسمها - وكذلك أجهزتها وخصوصاً الجهاز العصبي - تفرض عليها خصائص جنسها. والقوانين الفيسيولوجية تماماً مثل القوانين الفلكية ثابتة وغير قابلة للتغيير. فليس بالإمكان أن نخضعها لأهواء ورغبات الإنسان، بل نحن مضطرّون إلى أن نقبلها كما هي، والنساء يجب أن يجتهدن في إظهار مواهبهن الطبيعية بالطريقة التي تفرضها طبيعتهن بدون تقليد أعمى للرجال. دورهن في التكامل الإنساني أكبر بكثير من دور الرجال ولا ينبغي أن يتخلّين عنه ويهملنه).
وبعد أن يشرح (كارل) كيفية تكوّن حيمن الرجل وبويضة المرأة واتحادهما، ويشير إلى أنّ وجود الأنثى ضروري لاستمرار الرجل على خلاف وجود الذكر، وأنّ الحمل يكمل جسم وروح المرأة، يقول في الفصل الأخير: (يجب أن لا نربّي الشابات على نفس الطراز الفكري والحياتي ونفس الهدف والمثال الذي نربّي عليه الشبّان، ويجب على المتخصّصين في مجال التربية والتعليم أن يأخذوا الاختلافات العضوية والروحية بين الرجل والمرأة والواجبات الطبيعية لكل منهما بنظر الاعتبار، فإنّ التنبّه إلى هذه النقطة الأساسية مهم جدّاً في بناء مستقبل حضارتنا).
وكما تلاحظون فإنّ هذا العالم الكبير يشرح الفروق الطبيعية
الكثيرة بين المرأة والرجل ويعتقد أيضا أن الفروق تضع المرأة والرجل من ناحية الواجبات والحقوق في مواقع متباينة. وفي الفصل التالي سنعرض أيضا نظريات العلماء حول الفرق بين المرأة والرجل ثم نستنتج في أي الجوانب تتشابه استعداداتها واحتياجاتهما وتتشابه - تبعاً لذلك - حقوقهما، وفي أيّ الجوانب تتفاوت الاستعدادات، وتتفاوت - تبعاً لها - الحقوق والواجبات. وهذا القسم هو أكثر الأقسام حساسية عند بحث وتحديد الحقوق والتكاليف الأُسرية للمرأة والرجل.
الفصل السابع
فوارق المرأة والرجل
الفروق بين المرأة والرجل (1)
(الفروق بين المرأة والرجل! يا له من كلام منمّق، يظهر أنّه يوجد لحد الآن - ونحن في النصف الثاني من القرن العشرين - أشخاص يحملون أفكار القرون الوسطى ويتابعون فكرة الرق بين المرأة والرجل القديمة البالية، ويتصوّرون أنّ المرأة تختلف عن الرجل، ولابدّ أنّهم - كأهل القرون الوسطى - يريدون أن يتوصّلوا إلى أنّ المرأة جنس أدنى، إنسان ناقص، نقلة بين الحيوان والإنسان، وليست لائقة لأن تحيا حياة مستقلّة وحرّة، بل يجب أن تعيش تحت قيمومة وولاية الرجل، بينما أصبحت هذه الأفكار قديمة وبالية، وقد ثبت اليوم أنّ كل هذا الكلام كان كلام غش ألفه الرجل ظلماً في مرحلة التسلّط على المرأة، وثبت عكسه الآن، فالمرأة هي الجنس الأفضل والرجل هو الجنس الأدنى والأقل).
كلاّ، أيّها السيد، ففي القرن العشرين وفي ضوء التقدّم العلمي المحيّر، أصبحت الفوارق بين المرأة والرجل أكثر وضوحاً وتحديداً، وليست غشّاً وافتراءً، بل حقائق علمية تجريبية، لكن هذه الفوارق لا علاقة لها بكون المرأة أو الرجل جنساً أفضل، والثاني جنساً أدنى وأحقر وأنقص. فإنّ لقانون الخلقة قصداً آخر في ذلك، فهو قد أوجد هذه
الفوارق من أجل توثيق العلاقات العائلية بين المرأة والرجل وتقوية أساس الوحدة بينهما. أوجد هذه الفوارق من أجل أن يوزّع المسؤوليات بين المرأة والرجل ويحدّد لهما الحقوق والواجبات الأُسرية. وإنّ الهدف من إيجاده لهذه الفوارق شبيه بالهدف الذي من أجله أوجد الفوارق بين أعضاء الجسد الواحد؛ فهو حين عيّن مواقع العين والأذن واليد والرجل والعمود الفقري، لم يكن يفضّل عضواً على آخر ويحب عضواً ويكره آخر.
تناسب أم نقص وكمال
من المواضيع التي تثير عجبي إصرار البعض على أنّ الفوارق بين المرأة والرجل من حيث الجسم والعقل نقصاً في المرأة وكمالاً للرجل، ويدّعون أنّ قانون الخلقة قد خلق المرأة ناقصة لحكمة ما. واعتبار المرأة ناقصة كان مشتهراً في الغرب قبل ظهوره بين شعوب الشرق. فالغربيون كثيراً ما ظلموا المرأة بالطعن فيها واعتبارها ناقصة؛ إذ قالوا على لسان الكنيسة والدين: (إنّ المرأة يجب أن تخجل من كونها امرأة). وقالوا: (المرأة هي الموجود ذو الشعر الطويل والعقل القصير). و(المرأة آخر موجود وحشي دجّنه الرجل) و(المرأة نقلة بين الحيوان والإنسان) وأمثال ذلك.
وأعجب من هذا أن يستدير بعض الغربيين مئة وثمانين درجة ويريدون أن يثبتوا الآن بألف دليل ودليل أنّ الرجل موجود ناقص
الخلقة، وضيع وحقير، والمرأة موجود كامل وأفضل من الرجل. ولو قرأتم كتاب (المرأة الجنس الأفضل)(1) لأشلي مونتاغو، والذي ينشر في مجلة (إمرأة اليوم)(2) لرأيتم كيف يريد هذا الرجل - بمختلف التلفيقات وأقوال الزور - أن يثبت أنّ المرأة أكمل من الرجل. هذا الكتاب من حيث المعلومات الطبيّة والنفسية، والإحصاءات الاجتماعية التي يعرضها مباشرة؛ قيّم جداً، ولكن حين يقوم الكاتب نفسه بالاستنتاج من ذلك ما يريد أن يثبت به عنوان كتابه، تصل التلفيقات غايتها القصوى. لماذا يعتبرون المرأة يوماً بهذه الحقارة والدناءة لكي يضطرّوا في يوم آخر إلى أن يرفعوا عنها كل هذه النقائص ويلصقونها بالرجل؟ وما الداعي لاعتبار الفوارق بين المرأة والرجل نقصاً في أحداهما وكمالاً في الآخر لنكون مضطرّين إلى أن نحيف مرة على الرجل ومرّة على المرأة؟ يصر أشلي مونتاغو على أن يقدّم المرأة على أنّها أفضل من الرجل من الرجل من جهة، ويقوم من الجهة الأخرى بتعليل مميزات الرجل على أنّها نتيجة العوامل التاريخية والاجتماعية لا العوامل الطبيعية.
وعلى كل حال، فإنّ الفوارق بين الرجل والمرأة تناسب وليست نقصاً وكمالاً. وقد شاء قانون الخلقة أن يوجد - بهذه الفوارق - تناسباً
____________________
(1) بالفارسية كتاب (زن جنس برتر).
(2) بالفارسية (زن روز).
أكبر بين المرأة والرجل اللذين خلقا - قطعاً - لحياة مشتركة وما حياة العزوبة إلاّ انحراف عن هذا القانون، وسيتضح هذا الأمر عند عرض الفروق بين الجنسين.
نظرية أفلاطون
إنّ هذه الفكرة ليست حدثاً جديداً ظهر في قرننا هذا، إنّما ترجع في قدمها إلى ألفين وأربع مئة عام خلت؛ إذ إنّها قد طرحت على نفس هذه الصورة في كتاب (جمهورية أفلاطون) حيث يدّعي أفلاطون بصراحة تامّة أنّ للنساء والرجال استعدادات متشابهة، ويمكن لنساء أن يلتزمن بنفس واجبات الرجال ويتمتعن بنفس حقوقهم.
وعلى هذا فإنّ نواة جميع الأفكار الجديدة التي طرحت في القرن العشرين بخصوص المرأة وحتى تلك التي اعتبرت في نظر شعوب القرن العشرين متطرّفة وغير مقبولة، تجدها في أفكار أفلاطون وهذا ما جعله محل إعجاب المراقبين وهو المسمّى أبا الفلسفة. وقد بحث أفلاطون في الفصل الخامس من كتاب (الجمهورية) ضمن ما بحث؛ اشتراكية المرأة والطفل وإصلاح العنصر وتحسين النسل، وحرمان بعض النساء والرجال من التناسل وحصره بالأفراد الذين يتمتعون بميزات جيدة، وتربية الأولاد خارج محيط الأُسرة، وحصر التناسل في سنوات معيّنة من عمر المرأة والرجل هي سنوات القوّة والحيوية.
يعتقد أفلاطون أنّه كما يُدرّب الرجال على فنون الحرب كذلك
يجب أن تنال النساء نفس التدريب، وكما يشارك الرجال في المباريات الرياضية، كذلك النساء.
إلاّ أنّ هناك ملاحظتين على أقوال أفلاطون:
الأُولى: إنّه يعترف أنّ النساء أضعف من الرجال سواء في القوى البدنية أو القوى الروحية أو العقلية، أي أنّه يرى الفرق بين المرأة والرجل فرقاً (كمّيّاً) ويرفض كونهما مختلفين من ناحية الاستعدادات.
فهو يعتقد أنّ استعدادات المرأة والرجل واحدة. إلاّ أنّ النساء أضعف من الرجال في جميع الجوانب، هذا ما لا يدعو إلى أن تعمل النساء في مجالات غير مجالات عمل الرجال. وأفلاطون بسبب اعتقاده أنّ المرأة أضعف من الرجل، يشكر الله على أن خلقه رجلاً لا امرأة. فيقول (أشكر الله لأنّني خُلقت يونانياً لا غير يوناني، إنّني وُلدت حرّاً لا عبداً، وأنّني خُلقت رجلاً لا امرأة).
الثانية: أنّ أفلاطون فوض إلى الطبقة الحاكمة (الفلاسفة الحكام) مسائل تحسين النسل، والتنمية المتماثلة لاستعدادات المرأة والرجل، اشتراكية المرأة والطفل وغير ذلك، باعتبار أنّه يرى الحكام الفلاسفة أجدر الناس بتولي الحكم. وبما أنّنا نعلم أنّ أفلاطون في المجال السياسي يرفض الديمقراطية ويؤيّد الارستقراطية فإنّ ما قاله فيما مرّ يتعلّق بالطبقة الارستقراطية، وأمّا بالنسبة لغير هذه الطبقة فله رأي آخر.
أرسطو في مواجهة أفلاطون
وقد آلت آراء أفلاطون في العالم القديم من بعده إلى تلميذه أرسطو. ففي كتابه (السياسة) عرض أرسطو آراءه في الفوارق بين المرأة والرجل والتي خالف فيها أُستاذه أفلاطون مخالفة شديدة. فهو يؤمن أنّ الفرق بين المرأة والرجل ليس كمّيّاً فقط وإنّما كيفيّاً أيضاً. إنّه يقول إنّ استعدادات المرأة تختلف نوعاً عن استعدادات الرجل، وأنّ الواجبات التي ألقاها على عاتقهما قانون الخلقة، والحقوق التي أرادها لهما تختلف من جوانب كثيرة. وفي نظر أرسطو، إنّ الفضائل الأخلاقية للرجل والمرأة تتفاوت كذلك في كثير من المجالات، فما يمكن أن يعد فضيلة للرجل قد يعد خلاف ذلك عند المرأة، وما يعتب فضيلة عند المرأة قد لا يعتبر كذلك عند الرجل.
وقد نسخت نظريات أرسطو نظريات أفلاطون في العالم القديم، ورجّح العلماء الذين جاءوا بعدهما نظريات أرسطو على نظريات أفلاطون.
نظرة عالم اليوم
كان هذا ما يتعلّق بآراء العالم القديم، فلننظر ماذا يقول عالم اليوم؟ العالم الجديد لا يكتفي بالحدس والتخمين، إنّما اعتماده على المشاهدة والاختبار، والإحصاءات والأرقام، وما تراه العين. وفي العالم الجديد، وعلى ضوء الدراسات المعمّقة في الطب والنفس والمجتمع تمّ اكتشاف
فوارق أكثر وأكبر بين المرأة والرجل لم يكن يعرفها العالم القديم.
فشعوب العالم القديم إنّما كانت تقيم المرأة والرجل على أساس أنّ أحدهما أضخم والآخر أصغر، هذا أخشن وهذا أنعم، هذا أطول وهذا أقصر، صوت الرجل أخشن وصوت المرأة أنعم، شعر الرجل أكثف وشعر المرأة أقلّ كثافة، وكانوا على كل حال لا يتجاوزون في المقارنة أكثر من التفريق في سن البلوغ بين المرأة والرجل أو الفروق بين عقل ومشاعر كل منهما، فيجعلون الرجل مظهر العقل والاتزان والمرأة مظهر العاطفة والحب. أمّا اليوم فقد تمّ اكتشاف فوارق كثيرة علاوة على الفروق التي كانت معروفة من قبل. وسنذكر فيما يلي مجموع الفوارق التي حصلنا عليها من كتابات المحقّقين، ثم نقوم بشرح فلسفتها وتقسيمها إلى ما هو طبيعي وما هو نتيجة للعوامل التاريخية والثقافية والاجتماعية. والحقيقة أنّ قسماً من هذه الفروق يمكن إدراكه بقليل من التجربة والاطلاع والقسم الآخر بديهي لا يمكن إنكاره بحال من الأحوال.
نوعان متباينان من الناحية الجسمية
الرجل - بشكلٍ عام - أضخم جسماً، والمرأة أصغر جسماً... الرجل أطول والمرأة أقصر... الرجل خشن الملمس والمرأة ناعمة، صوت الرجل خشن وصوت المرأة رقيق، نمو جسم المرأة سريع، ونمو جسم الرجل بطيء، حتى ليقال إنّ الجنين الأُنثى أسرع نمواً من الجنين الذكر،
نمو عضلات الرجل وقواه البدنية أكثر من المرأة، مقاومة المرأة لكثير من الأمراض أكثر من مقاومة الرجل.
المرأة تبلغ رشدها أسرع من الرجل كما تبلغ سن اليأس على العكس من الرجل، كذلك البنت تبدأ بالكلام أسرع من الولد، معدل حجم دماغ الرجل أكبر من معدل حجم دماغ المرأة، ولكن لو أخذنا بنظر الاعتبار نسبة حجم الدماغ إلى حجم الجسم، لكان دماغ المرأة أكبر من دماغ الرجل... استيعاب رئة الرجل للهواء أكثر من استيعاب رئة المرأة، ضربات القلب المرأة أسرع من ضربات قلب الرجل.
من الناحية النفسية
يميل الرجل إلى الرياضة والصيد والأعمال الحركية أكثر من المرأة، الرجل يميل إلى المبارزة والقتال، والمرأة تميل إلى السلم والمؤانسة، الرجل أكثر تعدّياً وإثارة للصخب والمرأة أكثر هدوءاً وسكوناً.
المرأة تتجنّب استعمال الخشونة مع نفسها أو مع الآخرين ولذا نرى أنّ نسبة انتحار النساء أقل منها لدى الرجال. والرجال في كيفية الانتحار كذلك أقسى من المرأة.
فهم يستعملون المسدّس، يلقون بأنفسهم من مرتفع، أمّا
النساء فيستعملن الأقراص المنوّمة والترياك(1) وأمثال ذلك.
مشاعر المرأة أسرع تهيّجاً من مشاعر الرجل، أي أنّ المرأة في مجال الحب أو الخوف سريعة التأثّر والانفعال، والرجل أبطأ تأثّراً بهذه المشاعر، والمرأة بطبعها تهتم بزينتها وجمالها وبالموضات المختلفة بخلاف الرجل، مشاعر المرأة أقل ثباتاً من مشاعر الرجل، المرأة أكثر احتياطاً من الرجل وتديناً وثرثرة، وخوفاً ومجاملة.
مشاعر المرأة أُمومية وتظهر فيها منذ الطفولة، وحبّها للأُسرة وإدراكها الطبيعي لأهميّة المؤسسة العائلية أكثر من الرجل. المرأة في علوم الاستدلال والمسائل العقلية الجافّة لا تصل إلى مستوى الرجل لكنّها لا تقل عنه مهارة في الآداب والرسم وسائر المجالات التي ترتبط بالذوق والمشاعر، الرجل أقدر من المرأة على كتمان الإسرار - وحتى الأسرار التي تُعدّ مشكلة بالنسبة له - ولذا نجد الرجل أكثر من المرأة ابتلاءً بالأمراض الناتجة عن هذا الكتمان، المرأة أرق قلباً من الرجل وأسرع منه إلى البكاء وأحياناً إلى الحيلة.
____________________
(1) هو سائل يستخرج من جوز نبات الخشخاش فيجفف وهو مخدّر يستعمله كثير من المدمنين على المخدّرات، كما يدخل في تركيب كثير من الأدوية. المصحّح.
من ناحية المشاعر تجاه بعضهما
الرجل عبد شهوته والمرأة أسيرة حبّها للرجل، يحب المرأة التي تعجبه ويختارها، والمرأة تحب الرجل الذي يوليها اهتمامه ويظهر لها حبّه مسبقاً، الرجل يريد المرأة التي تتبعه ويسيطر عليها والمرأة تريد الاستيلاء على قلب الرجل والسيطرة عليه عن طريق قلبه، الرجل يريد أن يسيطر على المرأة عنوة، والمرأة تريد أن تسيطر على الرجل بالنفوذ إلى قلبه، الرجل يريد أن يأخذ المرأة والمرأة تريد أن تجذب الرجل، المرأة يعجبها في الرجل الشجاعة والإقدام والرجل يعجبه فيها الجمال والدلال، المرأة تعتبر حماية الرجل لها أغلى شيء لديها، وهي أقدر من الرجل على امتلاك شهوتها. وشهوة الرجل بادئة مهاجمة وشهوة المرأة تبرز بالإثارة.
الفروق بين المرأة والرجل (2)
نشرت مجلّة (امرأة اليوم)(1) نظرية بروفسور وعالم نفس أمريكي مشهور يدعى (بروفسور ريك) قضى سنوات طويلة في البحث في عادات المرأة والرجل وحصل على نتائج جيّدة، وقد نشر - في كتاب ضخم - الفروق التي لا تعد بين المرأة والرجل.
يقول البروفسور: (عالم الرجل يختلف عن عالم المرأة فإذا كانت
____________________
(1) (زن روز) باللغة الفارسية، العدد 90.
المرأة لا تستطيع أن تفكر أو تتصرف كالرجل، فإن هذا يدل على أن لكل منهما عالما مختلفا عن الآخر).
ويقول: (جاء في التوراة: خلق الرجل والمرأة من لحم واحد) نعم، بالرغم من أنّهما خلقا من لحم واحد، فإنّ لهما جسدين مختلفين ومتفاوتين كليّاً من حيث التركيب. وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ أحاسيس ومشاعر هذين الموجدين لن تتشابه في أيّ وقتٍ من الأوقات، ولن يحدث مطلقاً أن يكون لهما ردّ فعل واحد تجاه الأحداث، والمرأة والرجل - بحكم الاختلاف الطبيعي في الجنس - يتصرفان بنحوين مختلفين، ويتحرّكان كنجمتين في مدارين متباينين، إنّهما يفهمان بعضهما ويكملان بعضهما ولكنّهما لن يكونا شيئاً واحداً أبداً؛ لذا فهما يتمكنّان من العيش سوية، يعشق أحدهما الآخر ولا يمل أو ينزعج من صفاته وأخلاقه).
وقد أجرى البروفيسور ريك مقارنة بين مشاعر كل من المرأة والرجل وسجل الفروق بين الاثنين، ومن هذه الفروق قوله:
(يمل الرجل البقاء مدّة طويلة بجوار المرأة التي يحبها، أمّا المرأة فليس شيء ألذّ عندها من أن تكون دائماً على مقربة ممّن تحبّه.
* يحب الرجل أن يكون في كل أيّامه على حال واحدة. أمّا المرأة فتسعى لتصنع من نفسها إنساناً جديداً كل يوم وأن تنهض من فراشها كل يوم بوجه جديد.
* أحلى جملة يمكن أن يقولها رجل لامرأة هي عبارة (عزيزتي،
إنّني أحبّك).
* وأجمل عبارة تقولها المرأة للرجل الذي تحبّه هي عبارة (أنا فخورة بك).
* الرجل الذي كانت في حياته أكثر من امرأة يصبح محل إعجاب النساء الأُخريات، بينما لا يرتاح الرجال للمرأة التي كان لها في حياتها أكثر من رجل واحد.
* حين يهرم الرجال يشعرون بالتعاسة؛ لأنّهم قد فقدوا مصدر قوّتهم وهو القدرة على العمل، أمّا النساء المسنّات فيشعرن بالرضا؛ لأنّ أحسن شيء في نظرهن: بيت وعدد من الأحفاد.
* النجاح في نظر الرجال هو الحصول على مكانة اجتماعية مرموقة وشخصية موضع احترام كل أصناف المجتمع.
* والنجاح بالنسبة للمرأة امتلاك قلب رجل والاحتفاظ به طول العمر.
* ويسعى الرجل لأن يكسب المرأة التي يحب إلى دينه وجنسه.
* وكما يسهل على المرأة تغيير لقبها بعد الزواج طبقاً للقب زوجها؛ كذلك يسهل عليها تغيير دينها وجنسيتها من أجل الرجل الذي تحب).
آية الخلق
بغضّ النظر عن كون الفروق بين المرأة والرجل تستوجب التفاوت
في الحقوق والواجبات الأُسرية أم لا، فإنّ هذه المسألة هي أساساً من عجائب آيات الخلق، بل هي درس في التوحيد ومعرفة الله، ودليل على التنظيم الحكيم والدقيق للعالم، ونموذج واضح على غياب الصدفة في سير الخلق، وأنّ الطبيعة لا تجري أحداثها بصورة عشوائية، ودليل نيّر على أنّ موجودات الكون لا يمكن تفسير وجودها بدون اللجوء إلى قانون (العلّيّة).
ولقد أنشأت القدرة - من أجل تحقيق هدفها وحفظ النوع - جهازاً عظيماً لإدامة النسل ينتج دائماً في معمله جنس الذكر وجنس الأُنثى، وحين يستدعي بقاء النسل تعاون جنسين - خصوصاً في الإنسان - فإنّه من أجل أن يتعاون الجنسان على إنجاز هذا العمل؛ طرح فكرة وحدتهما واتحادهما، واستطاع أن يستبدل الأنانية وحب الذات - اللازمين لكلّ حي - بالخدمة والتعاون والتسامح والإيثار، ودفعهما إلى أن يسعيا إلى الحياة المشتركة. ومن أجل أن يحقّق الخطّة كاملة في الواقع ويوثق عرى العلاقة بينهما جسماً وروحاً؛ باين بين جسميهما روحيهما وهذا التباين هو الذي يجذب كل منهما نحو الآخر ويجعل منهما عاشقين لبعضهما. ولو كان للمرأة جسم وروح وأخلاق ورغبات الرجال لتعذّر عليها أن تجتذب الرجل نحوها وتحوّله إلى عاشق محب أمكن المرأة أن تعدّه فارس أحلامها وتظهر من فنونها ما تصطاد به قلبه. خلق الرجل ليسخر العالم وخلقت المرأة لتسخر الرجل. إنّ قانون
الخلقة جعل المرأة والرجل متعلقين ببعضهما وطالبين لكلّ منهما، لكن هذا التعلق ليس من نوع التعلق بالأشياء. فالتعلّق بالأشياء ناتج عن الأنانية، أي أنّ الإنسان يريد الأشياء لذاته ويتعامل معها على أنّها وسائل يريد أن يستخدمها من أجل توفير الرفاه لنفسه، أمّا الحب الزوجي فإنّه قد صنع بالصورة التي تجعل كلاّ من الزوجين يسعى من أجل سعادة ورفاه زوجه، ويتلذّذ بالإيثار والتضحية في سبيله.
علاقة أسمى من الشهوة
العجيب أنّ بعض الأفراد لا يستطيعون أن يفرّقوا بين الشهوة والرأفة، فيتصوّرون أن الذي يربط الزوجين ببعضهما يقتصر على الطمع والشهوة والرغبة في الاستخدام والاستغلال. تماماً كالشيء الذي يشد الإنسان إلى المأكولات والمشروبات والملبوسات ووسائل النقل. إنّهم لا يدركون أنّ في الخلقة والطبيعة دوافع أخرى إضافة إلى الأنانية وطلب المنفعة، وتلك الدوافع لم تنتج عن الأنانية، بل عن العلاقة المباشرة بالغير وهي السبب في نشوء التضحية والإيثار وتحمّل المشاق في سبيل راحة الغير، وأنّها هي التي تجسّد إنسانية الإنسان بل إنّ طرفاً منها - يعني ذلك الذي يرتبط بالزوج والولد - يشاهد أيضاً لدى الحيوانات، هؤلاء الأفراد يظنون أنّ الرجل ينظر إلى المرأة دائماً بتلك العين التي ينظر بها شاب أعزب إلى أيّة فتاة يراها في الشارع، أي إنّها - فقط - الشهوة التي تربط بين الاثنين وتشدّهما إلى بعضهما، في الوقت
الذي يوجد هناك رباط أسمى من الشهوة، وهو الأساس في وحدة الزوجين، وهذا الشيء هو ما عناه القرآن الكريم بكلمة (مودّة ورحمة) إذ يقول:
( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدّةً وَرَحْمَةً ) .
ما أكبره من خطأ أن نفسّر تاريخ علاقات المرأة والرجل فقط على أساس حسّ الاستخدام والاستغلال وتنازع البقاء، وما أكثر التفاهات التي تُحاك في هذا المجال، والحقيقة إنّني أعجب وآسف لجهل البعض حين أقرأ بعض ما كتب في تفسير تاريخ العلاقة بين المرأة والرجل، وأجد أنّ المبدأ الذي استندوا إليه أساساً هو مبدأ الصراع، فيفترضون أنّ المرأة والرجل مثل طبقتين اجتماعيتين دائمتي الصراع والتجاذب. فإذا استطعنا أن نفسّر تاريخ علاقة الآباء بالأبناء على أساس حسّ الاستخدام والاستغلال، عند ذاك لا يمكن أن نفسّر العلاقة التاريخية بين الزوجات والأزواج على نفس الأساس. صحيح أنّ الرجل كان دائماً أقوى من المرأة إلاّ أنّ قانون الخلقة قد صاغ غرائز الرجل بشكل لا يستسيغ ممارسة الظلم تجاه المرأة بالشكل الذي يمارسه مع غلمانه وعبيده وخدمه وجيرانه، كما أنّه لا يستسيغ ذلك الظلم لأولاده.
أنا لا أنكر ظلم الرجال للنساء، إنّما أنكر التفسير المطروح حول هذا الظلم. لقد مارس الرجال ضد النساء على طول التاريخ ظلماً كثيراً لكن دوافع هذا الظلم هي نفس الدوافع التي تحدو الرجل إلى ممارسة الظلم
ضدّ أولاده الذين يحرص كل الحرص على سعادتهم ومستقبلهم، هي نفس الدوافع التي تحدوه إلى ظلم نفسه. إنّ سببها الجهل والتعصّب والعادة وليس طلب المنفعة. أرجو أن تسنح لي فرصة في وقت مناسب أطرح فيها بحثاً مفصّلاً عن تفسير تاريخ العلاقة بين المرأة والرجل.
تفاوت مشاعر الرجل والمرأة تجاه بعضهما
إنّ العلاقة الأُسرية بين المرأة والرجل لا تختلف فقط عن علاقتهما بالأشياء بل إنّ علاقة أحدهما بالآخر هي الأخرى غير متشابهة، أي إنّ علاقة الرجل بالمرأة للمرأة، قد تمّت بعجلة شديدة لكونها جاءت متأخّرة. ولم تمهل الإحساسات العلم ليقول كلمته ويهتدي بهداه؛ لذا فقد أحرقت هذه النهضة الأخضر واليابس. تختلف عن علاقة المرأة بالرجل نوعاً. صحيح إنّها علاقة تجاذب بين طرفين، ولكنّها على عكس الجمادات، حيث يجذب الجسم الأصغر باتجاه الجسم الأكبر، فإنّ الخالق قد جعل الرجل مظهراً للطرف المحب العاشق الطالب، والمرأة مظهراً للطرف المحبوب المعشوق المطلوب. إحساسات الرجل تمثّل الحاجة، وإحساسات المرأة تمثّل الدلال، إحساسات الرجل طالبة، وإحساسات المرأة مطلوبة.
قبل فترة نشرت أحدى الصحف صورة شابة روسية كانت قد انتحرت، وقد كتبت في قصاصة ورق كانت قد تركتها ما يلي:
(لحد الآن لم يقبّلني رجل؛ لذا فإنّ هذه الحياة لم تعد تحتمل).
إنّ عدم حصول البنت على مَن يحبّها ويقبّلها يعتبر - بالنسبة لها - فشلاً ذريعاً. ولكن متى ييأس الشاب من الحياة؟ هل حين لا تقبّله فتاة أيضاً؟
كلاّ، بل حين يستطيع هو أن يقبّل فتاة.
يقول ويل ديورانت في بحوثه المفصلة والجامعة.
(ولو امتازت الفتاة بالعلم والتفكير ولم تحظ إلاّ بالقليل من الجاذبية وفنون الغنج والدلال فسوف لا توفّق كثيراً في الحصول على الزوج).
ثم يقول: (إنّ ستين بالمئة من فتيات الجامعة يبقين بلا أزواج، فهذه السيدة مونيا كوالوسكي - وهي عالمة بارزة - كانت تشكو من أنّ أحداً لم يتزوجها، وتتساءل: (لم لا يحبني أحد؟ إنّني أستطيع أن أكون أفضل من كثير من النساء، ومع ذلك فإنّ النساء اللواتي هنّ أقل أهميّة منّي يتجه إليهنّ الرجل بالحب، وأُترك أنا).
أرجو أن تلاحظوا أنّ نوع الإحساس بالفشل عند هذه السيدة يختلف عن نوع الإحساس بالفشل عند الرجل. إنّها تقول: (لماذا لا يحبني أحد؟) أمّا الرجل فإنّه يحس بالفشل في أمر الزواج إلاّ حين لا يجد المرأة التي ترضيه، أو أنّه إذا وجدها لم يستطع أن يخضعها لسلطانه.
ولكل ذلك فلسفة، هي تمتين وتعميق الصلة الواحدة. ولم هذه الصلة؟ هل هي من أجل أن تتلذّذ المرأة والرجل أكثر في الحياة؟ كلاّ،
ليس هذا فحسب بل إنّ أساس المجتمع الإنساني وتربية الجيل القادم قد بُني على ذلك.
نظريّة عالمة نفسانيّة
نقلت مجلة (المرأة اليوم)(1) بحثاً نفسياً كتبته عالمة نفسانية تُدعى كليف دالسون تقول فيه:
(باعتباري متخصّصة نفسانية فإنّ أكبر رغبة لديّ هي الاطلاع على نفسيات الرجال. وقبل فترة كُلّفت بعمل تحقيقات حول العوامل النفسية عند الرجل والمرأة، وقد توصّلت إلى هذا النتائج:
1 - ترغب جميع النساء بالعمل بإمرة شخص آخر. وبتعبير آخر: إنّهن يفضّلن أن يصبحن مرؤوسات بإشراف رئيس.
2 - تحب جميع النساء أن يشعرن أنّ وجودهن ذو أثر ومحل احتياج).
ثم تصوغ هذه السيدة رأيها كما يلي:
(في نظري أنّ هذين الاحتياجين الروحيّين للمرأة ينبعان من أنّ النساء يجرين وراء المشاعر والرجال يجرون وراء العقل. وكثيراً ما لوحظ أنّ السيدات في مجال الذكاء لا يوازين الرجال فحسب، بل يفضلنهم أحياناً. ونقطة ضعف السيدات تكمن فقط في إحساساتهن
____________________
(1) (زن روز) بالفارسية. العدد / 101.
المرهفة. الرجال يفكّرون دائماً بشكل عملي أكثر كما أنّهم يحكمون أحسن، وينظمون أحسن ويوجّهون بشكل أفضل؛ إذاً ففضل الرجال روحيّاً على النساء أمر خطّته الطبيعة. ومهما حاولت السيدات أن يدفعن هذه الحقيقة فلن يجديهن ذلك نفعاً، وبما أنّهن أكثر حسّاسية من الرجال، فقد وجب عليهن إذاً أن يتقبّلن حقيقة حاجتهن إلى إشراف الرجل عليهن في الحياة... والهدف الأعلى للسيّدات في الحياة هو (الأمن). فإذا نلن هذه الهدف، تركن العمل والنشاط... والمرأة من أجل الوصول إلى هذا الهدف تخشى مواجهة الأخطار. والأعمال التي تحتاج إلى التفكير الدائم تتعب المرأة وتضجرها).
النهضة العاجلة
إنّ النهضة التي قامت في أوروبا من أجل إحقاق الحقوق المهتضمة إذا أزاحت عن المرأة مجموعة تعاسات ومنحتها كثيراً من الحقوق وفتحت بوجهها الأبواب المغلقة، ولكنّها في المقابل جاءت بتعاسات ومشاكل جديدة للمرأة وللمجتمع الإنساني كلّه. ومن المسلّم به أنّ إحقاق الحقوق المرأة لو لم يتم بهذه العجلة لاتخذ صورة أفضل، ولما ارتفعت صيحات الحكماء إلى السماء من سوء أوضاع الحاضر ومخاطر المستقبل، ولكنّ الأمل ما يزال باقياً في أن يجد العلم طريقه في النهضة النسائية، وتعود هذه النهضة لتنهل من العلم بدلاً من التأثّر بالمشاعر كالسابق. وآراء علماء أوروبا في هذا المجال تبشّر بأنّ الأمور تسير في
هذا الاتجاه، والذي يظهر أنّ الأمور التي تبهر اليوم مقلّدي الغرب في باب علاقة المرأة والرجل قد تخطّاها الغربيون أنفسهم.
نظرية ويل ديورانت
ويل ديورانت في القسم الرابع من كتاب (لذات الفلسفة) يورد بحوثاً مفصّلة وجامعة حول المسائل الجنسية والأُسرية. وقد انتخبنا أجزاء مختصرة من هذا الكتاب لعرضها على القرّاء كي يطلعوا على التيارات الفكرية الموجودة بين علماء الغرب ولا يتعجّلوا بإصدار الأحكام.
يقول ويل ديورانت في القسم الرابع من الفصل السابع من هذا الكتاب تحت عنوان (الحب) ما يلي:
(أوّل نغمات الحب تبدأ مع اقتراب البلوغ، وكلمة البلوغ تقابلها كلمة (پيوبرتي) باللاتينية التي تعني (سن الشعر) وهي السن التي يبدأ فيها شعر الشبّان بالظهور، وخصوصاً شعر الصدر الذي يتباهون به، وشعر الوجه الذي يحلقونه بصبر كصبر (سي سي فوس)(1) . إنّ كيفية الشعر (في حالة سلامة الجوانب الأخرى) لها صلة - على ما يظهر - بالقوّة
____________________
(1) بالانكليزية رجل أسطوري يمثّل قمّة الصبر، ويقابله في الإسلام (صبر أيوب) ويقصد الكاتب بهذا أنّهم كانوا يتألّمون أثناء حلاقتهم له لعدم توفّر وسائل الحلاقة المريحة آنذاك.
التناسلية، أحسن وضع له هو عندما يبلغ النشاط الحيوي أوجه. هذا النمو المفاجئ للشعر يشكّل مع خشونة الصوت جزءاً من الصفات الجنسية الثانوية التي تظهر عند الشاب لدى البلوغ. أمّا الشابات فتمنحهن الطبيعة في هذه السن نعومة الأطراف والحركات التي تحيّر الناظرين، وسعة الحوض لتسهيل عمل الأُمومة، وامتلاء الصدور وبروزها من أجل إرضاع الأطفال. ولكن ما هو سبب ظهور هذه الصفات الثانوية؟ لا أحد يعلم، ولكن نظرية البروفيسور (ستارلينغ) في هذا الخصوص قد نالت مؤيّدين. بموجب هذه النظرية، تقوم الخلايا التناسلية ليس فقط بتوليد البويضة والحيمن بل تولّد أيضاً نوعاً من الهورمونات التي تفرز في الدم وتؤدّي إلى حدوث تغييرات جسمية ونفسية، وفي هذه السن، لا يتمتّع الجسم وحده بحيوية جديدة بل تظهر هناك آلاف التأثيرات المتنوّعة على النفس والطبيعة.
يقول رومن رولاند: خلال سنيّ الحياة، يأتي زمان تظهر على جسم الرجل تغييرات بطيئة... وعند المرأة يكون ما ذكرنا هو أهمّ هذه التغييرات... وتؤدّي القوّة والشجاعة إلى زيادة دقّات القلب، وتثير النعومة واللطف ميلاً ورغبة جامحة.
ويقول دموسيه: (كل الرجال كذّابون، ماكرون، ثرثارون، وذوو وجهين ومخاصمون، وكل النساء متكبّرات ويعشقن المظاهر وخائنات، وليس في العالم إلاّ شيء واحد مقدّس وسام، وذلك هو
اجتماع هذين الموجودين الناقصين...).
(آداب الزواج عند الكبار عبارة عن هجوم الرجال للاستيلاء، وتراجع النساء من أجل اجتذاب القلوب والمخادعة - وهناك بالطبع استثناءات في بعض الأحيان - ولأنّ الرجل مقاتل وحيوان مفترس بطبعه، فعمله ايجابي وهجومي، والمرأة بالنسبة له كجائزة يريد أن يستولي عليها ويمتلكها. فالبحث عن القرين حرب وكفاح، والزواج امتلاك واقتدار).
(العفّة الكافية لدى المرأة تخدم قضية التناسل؛ لأنّ امتناعها عن مهاجمة الرجال للحصول على القرين - بسبب الحياء والخجل - سيساعدها في اختيار الزوج المناسب. والعفّة تقوّي مكانة المرأة حيث يختارها الراغب بعد بحث كثير كي يفوز بمقام الأبوة لأولادها. إنّ مصلحة النوع والجماعة تظهر على لسان المرأة، كما أنّ مصلحة الفرد تظهر على لسان الرجل... وفي ممارسة الحب تكون المرأة أمهر من الرجل؛ لأنّ ميلها ليس من القوّة بحيث يحجب تأثير عقلها).
* وقد لاحظ داروين في أكثر الأنواع أنّ الأنثى لا رغبة لها في ممارسة الجنس.
ويقول لمبرزو، وكيش، وكرافت أبينغ: (أكثر ما تبتغيه النساء الرفاه والمديح المطلق والمبهم، وأكثر ما يرغبن فيه اهتمام الرجل برغباتهن، وهذا الأمر أقوى لديهن من الميل الجنسي).
ويقول لمبرزو: (إنّ الأساس الطبيعي للجانب الجنسي عند المرأة ليس إلاّ صفة ثانوية متفرّعة من الأمومة، كما أنّ جميع الإحساسات والعواطف التي تبديها للرجل لا تنبع من رغبات جسمية بل من غريزة الانقياد والتسليم للرجل، وقد جاءت هذه الغريزة من أجل ملاءمة الأوضاع).
ويقول ويل ديورانت في فصل تحت عنوان الرجال والنساء: (دور المرأة الخاص هو الإبقاء على النوع، ودور الرجل الخاص خدمة المرأة والطفل. ومن الممكن أن يكون لكلٍّ منهما أدوار أخرى، ولكن كل ما يقومان به من أعمال تابع لهذين الدورين الأساسيين على سبيل الحكمة والتدبير، وكل هذه مقاصد أساسية لكنّها غير متكاملة الوعي، يكمن فيها معنى الإنسان والسعادة، وطبيعة المرأة تفتقد الغريزة القتالية أصلاً، فإذا قاتلت الأنثى فمن أجل أطفالها).
* المرأة أكثر من الرجل، ومهما كانت شجاعة الرجل في الأمور الخطيرة وفي مواجهة مصاعب الحياة عظيمة، إلاّ أنّ التحمّل المستمر واليومي لدى المرأة في قبال المشاكل الصغيرة المتعدّدة أعظم... أمّا كفاح المرأة فيتمثّل بمظهر آخر، فالمرأة تحب الجنود وتعجب بالرجل القوي، ويثيرها عند مشاهدة مظاهر القوّة عامل عجيب - يدعى (ماسوشيستيك)(1) Masochistic حتى لو كانت تلك القوّة سبباً في
____________________
(1) Masochistic كلمة لاتينية تعني تحمّل العذاب من أجل التلذّذ به. المصحّح.
القضاء عليها).
*... هذا السرور القديم والتلذّذ بالقوّة والرجولة يغلب أحياناً على المشاعر الاقتصادية للمرأة؛ إذ إنّها ترجّح في بعض الأحيان الزواج من مجنون شجاع، والمرأة تستسلم بكل سرور للرجل ذي الإرادة القوية. وإذا كانت المرأة في هذه الأيام أقل طاعة من ذي قبل، فلأنّ القوّة والأخلاق عند الرجال أضعف اليوم من ذي قبل... إنّ اهتمام المرأة موجّه إلى الأمور العائلية، ومحيطها عادة البيت، إنّها كالطبيعة عميقة إلاّ أنّها كبيتها محدودة بحدود، وتشدّها الغريزة إلى العادات القديمة، إنّها ليست في الذهنية والعادة من أهل التجربة والاختيار (ويجب أن نستثني من ذلك بعض نساء المدن الكبرى)، وحتى إذا اتجهت إلى التحرّر الجنسي فليس ذلك لأنّها تستسيغه، وإنّما لأنّها يئست من الحصول على الرجل المؤهّل لتحمّل هذه المسؤولية فتتزوجه، وإذا افتتنت أحياناً في سن الشباب بالعبارات والمصطلحات السياسية وامتدّ اهتمامها إلى كافة الجوانب الإنسانية، فبعد العثور على الزوج الوفي تسدل - وكذلك زوجها - الستار على كل النشاطات السابقة، وتعلمه كيف يجب أن يكون وفاؤه مقصوراً على البيت فقط. والمرأة - من غير حاجة إلى مزيد من التفكير - تؤمن بأنّ الإصلاحات تبدأ من البيت. وهي في الوقت الذي تتمكّن فيه من أن تحوّل رجلاً شارد الذهن حائراً إلى رجل مضحٍّ ومنشد إلى البيت والأطفال تكون عامل حفظ وبقاء للنوع؛ إذ إنّ الطبيعة لا تهتم بالقوانين والحكومات إنّما تعشق البيت
والطفل، فإذا وفقت في المحافظة عليهما، فلا ارتباط ولا علاقة لها بالحكومات، وهي تسخر من الذين شغلوا أنفسهم في تغيير هذه القوانين الأساسية. وإذا عجزت الطبيعة - اليوم - عن حفظ البيت والطفل؛ فذلك لأنّ المرأة قد نسيتها لمدّة من الزمن، لكن هزيمة الطبيعة ليست دائمة، بل تستطيع في أيّ وقتٍ شاءت أن تؤمن مصالحها من ذخائرها، فهناك أقوام وعناصر أخرى أوسع وأكثر منّا تستطيع الطبيعة أن تؤمن دوامها الأكيد واللامحدود من خلالهم).
* * *
كان هذا بياناً قصيراً للفوارق بين المرأة والرجل ونظريات العلماء في هذا الباب.
كان بودّي أن أبحث تحت عنوان (سر الفوارق) إلى أيّ حد تمكّنت فيها العوامل التاريخية والاجتماعية أن تؤثّر في هذه الفوارق، ولكنّني أصرف النظر عن بحث ذلك إلى وقت آخر كي لا أطيل أمد البحث، ولكنّ الموضوع سيتضح كاملاً في البحوث القادمة.
الفصل الثامن
المهر والنفقة
(1) المهر والنفقة
من السنن القديمة جداً في العلاقات العائلية الإنسانية أنّ الرجل لدى الزواج يمنح المرأة (مهراً)، يهب شيئاً من ماله للمرأة أو لوالدها، وبالإضافة إلى ذلك يتعهّد بمصارف المرأة والأولاد طيلة الحياة الزوجية.
فما هي جذور هذه السنّة؟ ولماذا وكيف ظهرت؟ وأيّ صيغة يمثّل هذا المهر؟ ولماذا الإنفاق على المرأة؟ وهل - إذا نال كل من المرأة والرجل حقوقهما الطبيعية والإنسانية وحكمتهما العلاقات العادلة والإنسانية وعوملت المرأة كإنسان - يبقى موجب للمهر والنفقة؟ أم أنّ المهر والنفقة يمثّلان ذكرى عصور تملك الرجل للمرأة، وأنّ متقضى العدالة ومساواة حقوق الإنسان - خصوصاً في القرن العشرين - أن يلغى المهر والنفقة، فتعقد الزيجات بدون مهر، وتتعهّد المرأة بمسؤولية حياتها المالية، وتشارك الرجل بالتساوي في النفقة على الأولاد أيضاً.
نبدأ حديثنا الآن عن المهر لنرى كيف وجد؟ وما هي فلسفته وكيف يفسّر علماء الاجتماع وجوده؟
تاريخ المهر
يقال انه في زمان ما قبل التاريخ كان البشر يعيشون بطريقة وحشية، وكانت هناك طريقة تجمعهم تأخذ شكل القبيلة، ولأسباب مجهولة، كان الزواج بالأقرب غير جائز فكان شباب القبيلة الذين يبغون الزواج يظطرّون إلى أن يقصدوا القبائل الأخرى لاختيار زوجة أو حبيبة، وفي ذلك الزمان لم يكن الرجل يدرك دوره في إنجاب الأولاد. أي أنّه لم يكن يعلم أن لقاه بالزوجة هو الذي يؤدّي إلى الإنجاب فكان يعتبر الأولاد أولاداً لزوجته لا له، وكان يعجز عن تفسير شبه أولاده به ولا يدرك دلالته. وبالنتيجة فإنّ الأولاد أنفسهم كانوا يعدّون أنفسهم أولاد أُمّهم لا أولاد زوجها، وكان النسب يحدّد عن طريق الأُمّهات لا الآباء. فكان الرجال يعدّون موجودات عقيمة، وبعد الزواج يعيش الرجل بين قبيلة زوجته بوصفه إنساناً طفيلياً تحتاجه المرأة رفيقاً وتحتاج إلى وجود قوّته البدنية. هذه المرحلة هي مرحلة سلطة الأم.
ولم يمض طويل وقت حتى شعر الرجل بدوره في إنجاب الأطفال، وعدّ نفسه المالك الرئيس لهم، ومنذ ذلك الوقت أصبحت الزوجة تابعة له، وتسلّم هو رئاسة الأسرة وبدأت ما تسمّى مرحلة (سلطة الأب). وفي هذه المرحلة بقي الزواج من الأقارب ممنوعاً أيضاً، وكان الرجل مضطرّاً إلى اختيار زوجته من قبيلة أُخرى ليأتي بها إلى قبيلته. وبما أنّ
حالة الحرب والصدام هي التي كانت سائدة بين القبائل، فقد اتخذ اختيار الزوجة صورة اختطاف الفتاة، أي أنّ الشاب يجب أن يختطف الفتاة التي تعجبه من قبيلة أخرى.
وبالتدريج حلّ الصلح محل الحرب، وبدأت القبائل المختلفة تتعايش سلميّاً فيما بينها. وفي هذه المرحلة، نُسخ عرف اختطاف الفتاة وصار الرجل الذي يرغب في الاقتران بفتاة، يذهب إلى قبيلتها ليصبح أجير والدها ويعمل لديه لمدّة من الوقت فيزوّجه ذاك ابنته مقابل خدماته ثم يعود بالفتاة إلى قبيلته.
وبعد أن ازدادت الثروة لدى الناس، ارتأى الرجل تقديم هدية مناسبة لوالد الفتاة مقابل الزواج منها بدل أن يعمل لديه أجيراً لعدّة سنين. لقد نفذت هذه الفكرة ومن هنا كان (المهر). وعلى ذلك، ففي المراحل البدائية عاش الرجل طفيلياً على المرأة وخادماً لها، وكانت المرأة تحكمه. وفي المرحلة الثانية حيث صار الحكم بيد الرجل أصبح الرجل يختطف المرأة من القبيلة الأخرى. وفي المرحلة الثالثة صار الرجل - من أجل الفوز بالفتاة - يذهب إلى بيت والدها ويعمل لديه أجيراً لعدّة سنوات. وفي المرحلة الرابعة أصبح الرجل يقدّم مبلغاً بصفة (هدية) إلى والد الفتاة ومن هنا نشأت عادة المهر.
يقولون إنّ الرجل منذ أن قضى على نظام (سلطة الأم) وأسّس نظام سلطة الأب، أصبح يعامل المرأة كأمة أو - في أحسن الأحوال -
كأجيرة له، وينظر إليها كسلعة تنفعه أحياناً في تسكين شهوته. ولم يمنحها أيّ استقلال اجتماعي أو اقتصادي. كما أنّ ناتج عملها وجهدها ملك لغيرها أباً كان أو زوجاً. ولم يكن للمرأة حق في اختيار زوجها، ولا في أن تعمل طبقاً لرغبتها أو يكون لها ناتج نشاطها الاقتصادي والمالي، في الحقيقة إنّ المال الذي كان يدفعه الرجل مهراً، والنفقات التي يبذلها بوصفها نفقة، كان يقبضها فائدة اقتصادية تؤدّيها المرأة خلال فترة زواجها.
المهر في النظام الحقوقي الإسلامي
وهناك مرحلة خامسة سكت عنها علماء الاجتماع والمتحدّثون. في هذه مرحلة يقدم الرجل لدى الزواج (هدية) إلى زوجته لا يحق لوالديها التصرّف بها، وفي نفس الوقت الذي تتسلّم فيه المرأة هدية الرجل، تحفظ أيضاً استقلالها الاجتماعي والاقتصادي كما يلي:
أولاً: تختار زوجها بإرادتها لا بإرادة الأب أو أخ.
ثانياً: في الفترة التي تقضيها في دار أبيها، وكذلك في الفترة التي تقضيها في دار زوجها لا يحق لأحد أن يستخدمها أو يستغلّها، وعائد عملها وجهدها يكون لها لغيرها، ولا تحتاج إلى قيمومة الرجل عليها في معاملاتها الحقوقية.
والرجل من حيث استفادته من المرأة ليس له الحق في أن يتصل بها إلاّ في فترة الزواج، وهو ملزم - مادام زوجها وعلى صلة بها - أن
يؤمن معيشتها في حدود إمكاناته. هذه المرحلة هي التي ارتضاها الإسلام وبنى بنيانه عليها. ففي القرآن الكريم آيات كثيرة تذكر أنّ مهر المرأة ملك لها لا لغيرها. والرجل خلال فترة الزواج ملزم بتأمين احتياجات المرأة، وفي نفس الوقت يكون عائد عمل المرأة لها لا لغيرها - أباً كان أو زوجاً - وهنا تتخذ مسألة المهر والنفقة شكل اللغز، فإذا كان المهر يدفع لوالد الفتاة وتحمل هي إلى بيت زوجها - كالأمة - حيث يقوم الزوج باستغلالها، تصبح فلسفة المهر ثمن شراء الفتاة من والدها، وفلسفة النفقة ما ينفقه كل مالك على مملوكه. فإذا تقرّر ألاّ يدفع لوالد الفتاة شيء ولم يكن للزوج حق استغلال زوجته والانتفاع بمواردها الاقتصادية، وصار للمرأة استقلال اقتصادي كامل ولم تكن هناك حاجة - من الناحية الحقوقية - لوجود قيّم ووصي على المرأة، فلماذا إذاً يدفع المهر وتصرف النفقة؟
نظرة في التأريخ
إذا أردنا أن نتابع فلسفة المهر والنفقة في المرحلة الخامسة، يجب أن نعود قليلاً إلى المراحل الأربع السابقة. الحقيقة أنّ كل ما قيل في هذه المراحل ليس إلاّ سلسلة افتراضات وتخمينات وليست حقائق تاريخية أو علمية أو تجريبية. ومنشأ بعض القرائن من جهة وبعض الفرضيات الفلسفية حول الإنسان والعالم من جهة أخرى، وما قيل عن
مرحلة ما يُسمّى بـ (سلطة الأم) ليس ممّا يمكن تصديقه بسهولة، كذلك ما قيل عن بيع الآباء لفتياتهم واستغلال الزوجات من قِبل أزواجهن.
وفي هذه الافتراضات والتخمينات يلفت أنظارنا شيئان:
الأول: إنّهم حرصوا على تصوير تأريخ الإنسان الأول بالقسوة المتناهية، والخشونة ومجانبة العواطف الإنسانية.
الثاني: إنّهم تجاهلوا دور الطبيعة من حيث التدابير المحيّرة التي وضعتها من أجل الوصول إلى أهدافها الكليّة.
مثل هذه التصوّرات والآراء حول الإنسان والطبيعة، مقبولة عند الإنسان الغربي. أمّا بالنسبة للإنسان الشرقي - إذا لم يكن مقلّداً للغرب - فغير مقبولة؛ ذلك أنّ الغربي بعيد عن العواطف الإنسانية لأسباب خاصة، فليس بإمكانه أن يرى للعاطفة والحرارة الإنسانية دوراً أساسياً في التاريخ. فإذا انطلق الغربي من ناحية الاقتصاد لم ير إلاّ الخبز، فالتاريخ - في نظره - ماكنة لا تعمل إلاّ إذا أطعمتها الخبز. وإذا انطلق من المسائل الجنسية عد الإنسانية وتاريخ الإنسانية - مع كل صور الثقافة والفن والأخلاق والدين ومع كل التوجهات الروحية السامية - مجرّد ألاعيب تعبّر عن حالات متطوّرة للميول الجنسية. وإذا انطلق من حب الظهور والسيادة كان تاريخ البشرية في نظره سلسلة متصلة من نزف الدم والقساوة.
عانى الإنسان الغربي في القرون الوسطى من الدين وباسم الدين
من التعذيب والآلام، وشاهد حالات إلقاء أحياء من البشر في النار؛ ولهذا صار يفزع من اسم الله والدين وكل ما تشم منه رائحة ذلك. وبالرغم من جميع الآثار والأدلّة العلمية المتعددة على وجود الهادفية في الطبيعة وعدم ترك العالم بدون هدف إلاّ أنّه لا يجد في نفسه الجرأة الكافية للاعتراف بمبدأ (العلّية).
إنّنا لا نريد من مفسّري التاريخ أن يعترفوا بوجود الأنبياء الذين ظهروا على مدار التاريخ، ونادوا بالعدل والإنسانية، وحاربوا الانحرافات وحصلوا على نتائج مثمرة من مجاهداتهم، إنّما نريد منهم ألاّ ينسوا - على الأقل - الدور الواعي للطبيعة.
في تاريخ العلاقة بين المرأة والرجل وقعت مظالم كثيرة وقسوة لا تتصوّر، وقد تحدّث القرآن عن أشد هذه المظالم قسوة، إلاّ أنّه لا يمكن القول إنّ هذه القسوة والخشونة قد وُجدت على طول التاريخ.
الفلسفة الحقيقية للمهر
إنّ المهر - في رأينا - قد وجد نتيجة تدبير ذكي في أصل الخلقة من أجل تمتين علاقة المرأة بالرجل وتماسكها.
وُجد المهر لأنّ دور كل من المرأة والرجل في مسألة الحب مختلف في أصل الخلقة، وهذا القانون يسري - عرفاً - على الوجود بأجمعه إذ يقال إنّ قانون الحب والجاذب والمجذوب يسري على جميع الموجودات والمخلوقات، مع خاصية مفادها يجب أداؤه، فطبق عليها
جميعا قاعدة (الاحتراق بنار العذاب من جهة، والصبر عليه وعدم الشكوى منه من جهة أخرى).
يقول الشاعر المعروف ما ترجمته:
وتر الطرب لا يعرفه غير العاشق أيّ وتر هو؟
ذاك الذي من ألم جرحه ضجّت الأفلاك التسعة
إذا عرفت السر الذي خلف هذه الستارة
لعلمت لماذا قيدت الحقيقة بقيد المجاز
العشق هو الذي يبدو كل لحظة بلون
فهو دلال في مكان واحتياج في آخر
كل ما يظهر على وجه العاشق تحرّق
وكل ما يبدو على المعشوق تحمّل وصبر
لقد ذكرنا في إحدى مقالات هذه السلسلة - حيث بيّنا الفوارق بين المرأة والرجل - أنّ مشاعر المرأة والرجل تجاه كل منهما ليست متشابهة. فقانون الخلقة قد منح المرأة الجمال والغرور والاستغناء، ومنح الرجل الاحتياج والطلب والعشق والتغزّل فعادل ضعف المرأة في مقابل قوّة الرجل بهذه الطريقة، وهكذا نجد الرجل هو الذي يذهب لخطبة المرأة، وكما رأينا من قبل طبقاً لأقوال علماء الاجتماع في مرحلة سلطة الأم كما في مرحلة سلطة الأب أنّ الرجل هو الذي يبحث عن المرأة.
يقول العلماء: الرجل أكثر شهوة من المرأة، وقد ورد في الروايات الإسلامية أنّ الرجل ليس أكثر شهوة من المرأة بل على العكس من ذلك، إلاّ أنّ المرأة خلقت أكثر من الرجل قابلية على مقاومة شهوتها، ونتيجة الكلامين واحدة، ففي كلتا الحالتين يكون الرجل تجاه غريزته أضعف من المرأة، وهذه الخاصية أضفت على المرأة مزية هي ألاّ تذهب في طلب الرجل ولا تستسلم له بسهولة، بل على العكس من ذلك اضطر الرجل إلى إظهار حاجته إلى المرأة والمبادرة إلى جلب رضاها، وكان من هذه المبادرات - من أجل جلب رضاها واحترام رغبتها - أن يقدّم لها هدية.
لماذا يتنافس الذكور دائماً من أجل الفوز بصحبة الأنثى وتقع بينهم الحروب والمنازعات لذلك، أمّا في الإناث فلا يحدث أبداً أن يظهر الحرص والولع لاصطحاب الذكر؟ السبب هو أنّ دور الذكر غير دور الأنثى. فجنس الذكر اقترن بدور الطالب وجنس الأنثى لم يطلب جنس الذكر بحرص وولع مطلقاً، بل يظهر نوعاً من الاستغناء وعدم الحاجة.
وللمهر جذر مشترك مع حياء وعفّة المرأة، فقد أدركت المرأة بإلهام فطري أنّ عزّتها واحترامها يقضيان بأن لا تسلّم نفسها للرجل مجّاناً: أي - كما يصطلح عليه - أن تعرض سلعتها بثمن غال.
وقد أدّى ذلك كلّه إلى أن تستطيع المرأة - مع ضعفها الجسمي - جرّ الرجل إلى ساحتها خاطباً، وتدفع الرجال إلى التنافس من أجلها، كما
أنّها - بإخراج نفسها من متناول يد الرجل - صنعت الحب الرومانتيكي فصار كل مجنون يعدو خلف ليلاه، وحين ترضى بالزواج من الرجل تتسلّم منه هدية دليلاً على الصداقة.
يقولون إنّه في بعض القبائل المتوحّشة، حين تواجه الفتاة بعدد من الطلاّب والعشّاق المولهين، تدعوهم إلى منازلة بعضهم، فأيّهم غلب الآخر أو قتله، فقد أثبت لياقته للزواج منها.
وقد كتبت صحف طهران قبل مدّة، أنّ فتاة دفعت بشابين إلى (البراز) في طهران حين تنافسا في خطبتها، وقد اشتبك الاثنان بالسلاح الأبيض وهي حاضرة.
وفي نظر الأشخاص الذين يرون القدرة فقط في قوّة الساعد - و يرون تاريخ علاقة المرأة بالرجل حلقات متصلة من الظلم والاستغلال من قبل الرجل لا يصدقون أنّ المرأة - هذا المخلوق الضعيف والظريف - تستطيع أن تدفع أفراد الجنس الخشن إلى التنازع فيما بينهم. ولكن الشخص الذي له أدنى اطلاع على التدابير الماهرة للخالق والقدرة العجيبة والذكية التي عبّأها في وجود المرأة يعلم أنّ هذا الشيء ليس بعجيب أبداً.
إنّ للمرأة على الرجل تأثيراً كبيراً، وتأثيرها فيه أكبر من تأثيره فيها، فالرجل في كثير من فنونه وشجاعته وإقداماته ونبوغه وشخصيته مدين للمرأة، وإنّ التمنّع الظريف للمرأة مدين لحيائها وعفافها، أي مدين
إلى (العرض الغالي) للمرأة. المرأة دائماً تصنع الرجل، والرجل دائماً يصنع المجتمع، وفي الوقت الذي يذهب حياء المرأة وعفافها وامتناعها، وتبادر إلى ممارسة دور الرجل، ينتفي دورها، وينسى الرجل رجولته، فينهدم المجتمع في النهاية.
هذه القدرة، التي حفظت للمرأة شخصيتها طول التاريخ، وصانتها من الركض وراء الرجل، وجعلت الرجل يقصد ساحتها كخاطب، ودفعت الرجال إلى التنافس والتخاصم من أجلها إلى حد القتل، وجعلت شعارها الحياء والعفاف وسترت جسدها عن عيني الرجل... وجعلت منها شخصية محفوفة بالأسرار، ملهمة الرجل وخلاقة عشقه ومنبع فنه وشجاعته، ونبوغه... أوجدت في ذاته حس (التغزّل) والمدح ودفعته إلى التواضع ونكران ذاته أمامها؛ هي التي جعلت الرجل يقدّم للمرأة عند الزواج هدية باسم المهر.
المهر مادّة في قانون عام صبّت في أساس الخلقة وهيئت بيد الفطرة.
المهر في القرآن
القرآن الكريم لم يخترع المهر بالصورة التي ذكرناها في المرحلة الخامسة. المهر بهذه الصورة هو إبداع الخلقة، ودور القرآن إنّما هو إعادة المهر إلى حالته الفطرية.
يقول القرآن الكريم بلطف وظرف منقطعي النظير:( وَآتُوا النِّسَاءَ
صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) (1) ، أي أعطوا النساء مهورهن - التي هي ملك لهن - بأيديهن لا بأيدي الآباء أو الإخوة. إنّها هداياكم إليهن.
والقرآن الكريم في هذه الجملة القصيرة أشار إلى ثلاث نقاط:
أولاً: سمّى المهر (صدقة) بضم الدال والصدقة مشتقة من مادة (صدق) ولذا يسمّى المهر صداقاً أو صدقة لدلالته على صدق العلاقة مع الرجل، وقد أشار إلى هذه النقطة بعض المفسّرين كصاحب الكشّاف، وكذلك أورد الراغب الأصفهاني في مفردات غريب القرآن أنّ الصدقة (بفتح الدال) سمّيت كذلك لأنّها دليل على صدق الإيمان.
ثانياً: بإلحاق ضمير (هنّ) بالصدقات أراد عزّ وجل أن يشير إلى تعلّق المهر بنفس المرأة لا بالأب والأُم؛ لأنّ المهر ليس أجرة التربية والإرضاع والإطعام وغيرها من الخدمات التي قدّماها.
ثالثاً: إنّه باستعمال كلمة (نحلة) يصرّح بوضوح أنّ المهر ليس له عنوان غير الهدية والمنحة فحسب.
تفاوت المشاعر لدى الحيوانات
في جميع الأحياء - وليس الإنسان وحده - وحيثما كان قانون الجنسين حاكماً، وكان الجنسان محتاجين إلى بعضهما خلق جنس الذكر أكثر احتياجاً إلى جنس الأنثى، أي أنّ مشاعره ذاتها أكثر
____________________
(1) سورة النساء، الآية 4.
احتياجاً إلى الأنثى. وهذا بدوره أدّى إلى أن يخطو الذكر خطوات على طريق جلب رضاها، وكان سبباً في إصلاح علاقة الجنسين، فلا يستغل الذكر قوّته ضد الأنثى بل يلتزم جانب التواضع والخضوع أمامها.
الهديّة في العلاقات اللاشرعيّة
ولا يقتصر ذلك على الزواج والرباط الشرعي لعلاقات الجنسين، بل كلّما أراد (المرأة والرجل) أن يتلذّذا ببعضهما أو يمارسا ما اصطلح عليه باسم الحب الحر، كان الرجل هو الذي يقدم للمرأة هدية. وإذا ما تناولا معاً القهوة أو الشاي أو وجبة غذاء أحياناً نجد الرجل يدرك واجبه في أن يكون هو الذي يدفع ثمن ذلك. وترى المرأة أنّ من الإهانة لها أن تبذل مالاً من أجل الرجل. إنّ عبث ومجون الشاب يتطلّب أن يكون لديه مال. وعبث الفتاة وسيلة للحصول على الأموال. هذه العادات التي تجري حتى في العلاقات غير المشروعة وغير القانونية منشؤها اختلاف نوع المشاعر التي تكنّها المرأة والرجل لبعضهما.
العشق عند الغربيين أكثر طبيعية من الزواج
في العالم الغربي، غيّروا الوجه الطبيعي لمسألة المساواة في الحقوق الأُسرية بعنوان المساواة في حقوق الإنسان، وهم يسعون - خلافاً لقانون الطبيعة - إلى أن يضعوا المرأة والرجل في مواقع متشابهة ويعهدوا إليهما بأدوار متشابهة في الحياة العائلية، ولكنّا نرى أنّ المسألة حين تتصل بما يسمّى بالحب الحر ويكون تصرّف الرجل خارجاً عن سلطة
القوانين الوضعية، يقوم الأخير بواجبه الطبيعي تجاه المرأة متمثّلاً بالاحتياج والطلب وتقديم المال وبذل المصاريف، ويقدم الهدية إلى المرأة ويتحمّل نفقاتها، بينما في الزواج الغربي لا وجود للمهر، كما يعهد إلى المرأة بمسؤولية ثقيلة من ناحية نفقتها. أي أنّ الحب العربي أكثر انسجاماً مع الطبيعة من الزواج الغربي.
المهر وسيلة من الوسائل التي تجسّد لنا أنّ المرأة والرجل قد خلقا باستعدادات غير متشابهة، وأنّ قانون الخلق قد منح كلاًّ منهما سندات متفاوتة من حيث الحقوق الفطرية والطبيعية.
(2) المهر والنفقة
ذكرنا في الفصل السابق الفلسفة والعلّة الرئيسة لظهور المهر، ووضّح أنّ المهر إنّما وجد لأنّ قانون الخلقة في علاقات الجنسين قد عهد لكل منهما بدور متميز، كما ظهر أنّ المهر نشأ عن المشاعر الرقيقة والعاطفية لدى الرجل وليس عن مشاعر الخشونة والتملّك. أمّا فيما يتعلّق - من هذا الجانب - بالمرأة، فهو مشاعر التمنّع لديها لا الضعف ولا فقدان الإرادة. وما المهر إلاّ تدبير وضعه قانون الخلقة من أجل رفع قيمة المرأة ووضعها في مستوى أرفع. إنّ المهر يمنح المرأة شخصيتها، وأنّ قيمته المعنوية بالنسبة للمرأة أكبر من قيمته المادية.
العادات الجاهلية التي نسخها الإسلام
نسخ القرآن الكريم عادات الجاهلية حول مسألة المهر وأعادها إلى حالتها الطبيعية الأُولى.
ففي الجاهلية كان الآباء والأُمّهات يعتبرون المهر ثمن إرضاع الفتاة وثمن الأتعاب والجهود التي بذلوها لها منذ الطفولة حتى الزواج. وقد ورد في تفسير الكشّاف وغيره: أنّه حين كان يولد لأحدهم فتاة ويريد آخر أن يهنّئه يقول له: (هنيئاً لك النافجة) أي الزيادة في الثروة، يقصد أنّها ستجلب له مالاً حين تشب وتتزوّج ويدفع له مهرها.
وفي الجاهلية كان الآباء - وعند عدم وجودهم فالإخوة من بعدهم - يتبادلون الفتيات مع الآباء أو الإخوة الآخرين باعتبارهم أولياء الفتاة والقيّمين عليها وهم الذين يزوّجونها حسب رغبتهم لا رغبتها، هذا من جهة ومن جهة أُخرى فإنّهم يعتبرون مهر الفتاة ملكاً لهم لا لها، فكان الرجل يقول للآخر: زوّجتك من ابنتي أو أختي في مقابل تزويجك لي من ابنتك أو أختك، ويقبل الآخر قوله، وبذلك تصح كل فتاة مهراً للأخرى وتلحق بأبي أو أخي صاحبتها. هذا النوع من النكاح كان يسمّى نكاح (الشغار).
وقد نسخ الإسلام هذه العادة، بقول الرسول (صلّى الله عليه وآله): (لا شغار في الإسلام).
وجاء في الروايات الإسلامية أنّ الأب ليس فاقداً الحق في مهر ابنته فحسب ولكن حتى لو اشترط للأب في عقد الزواج شيء منفصل
عن مهر الفتاة وأعطي المهر لنفس الفتاة، صح العقد وبطل الشرط، أي أنّ الأب لا حقّ له في أن يستفيد شيئاً لنفسه من تزويج ابنته، حتى لو كانت هذه الفائدة منفصلة عن المهر.
وألغى الإسلام - أيضاً - عادة عمل العريس عند والد الفتاة التي يذكر علماء الاجتماع أنّها كانت موجودة في المراحل التي لم تكن الثروة قابلة للمبادلة. لكن عمل العريس عند والد فتاته لم يكن فقط بسبب أنّ الأب كان يرغب في الإفادة من بناته، وإنّما كانت هناك جذور أخرى للمسألة ترتبط أحيانا بتلك المرحلة من التمدّن، ولم يكن هذا الأمر - بحد ذاته - ظلماً. وعلى كل حال فمثل هذه العادة كانت موجودة قطعاً في العالم القديم.
وقصّة موسى وشعيب التي وردت في القرآن الكريم تشير إلى وجود مثل هذه العادة. فموسى في أثناء فراره من مصر، وحين وصل إلى بئر (مدين) أشفق على ابنتي شعيب اللتين كانتا تنتظران إلى جانب أغنامهما حين لم يرحمهما أحد، فسقى موسى لهما. وحين عادت الفتاتان إلى أبيهما، وقصّتا عليه أحداث اليوم، بعث إحداهما في إثره فدعته إلى البيت، وبعد أن تعارف موسى وشعيب، قال شعيب لموسى ذات يوم إنّي أريد أن أزوّجك إحدى ابنتي هاتين على أن تعمل عندي مدّة ثماني سنوات، وإذا رغبت أن تضيف من عندك سنتين، فيصبح عملك عندي عشر سنوات، فقبل موسى وأصبح صهر شعيب. كانت هذه
العادة موجودة في ذلك الزمان وتعود أسبابها إلى أمرين:
الأوّل: عدم وجود النقود آنذاك، فكانت الخدمة التي يمكن أن يؤدّيها العريس - للمرأة أو لأبيها - محصورة غالباً في العمل لهما.
الثاني: عادة تجهيز الفتاة، يعتقد علماء الاجتماع أنّ عادة تجهيز الفتاة من قبل الأب هي من العادات والسنن القديمة. فلكي يتمكّن والد الفتاة من توفير جهازها يتخذ من العريس أجيراً عنده أو يتسلّم منه مقداراً من النقود، ويكون ما يأخذه الأب من العريس لمصلحة الفتاة ولها.
على كل حال، فقد أُلغيت هذه القاعدة في الإسلام، ولم يعد لوالد الفتاة أن يعد مهرها مالا له، حتى ولو كان هدفه صرفه من أجل ابنته. إنّما الفتاة نفسها هي التي تملك حق التصرّف في المال فتصرفه على أي نحو تشاء. وتصرّح الروايات الإسلامية أنّ مثل هذا المهر غير جائز في المرحلة الإسلامية.
وفي الجاهلية، كانت هناك عادات أُخرى تؤدّي عملياً إلى حرمان المرأة من مهرها، من هذه العادات توارث الزوجية، فإذا مات الرجل كان وارثوه من قبيل الأبناء، والإخوة يرثون الزواج من أرملته بعد موته كما يرثون ثروته، فيتصوّر ابن أو أخو الميت أنّ له حق الزوجية الذي كان للميت، ويرى نفسه مخيّراً بين أن يزوّج أرملة المتوفّى من آخر ويقبض قيمة مهرها أو يتخذها زوجة له بدون مهر جديد بل بموجب
نفس المهر الذي كان الميت قد دفعه لها من قبل.
وقد ألغى القرآن الكريم إرث الزوجة بقوله:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً ) (1) .
والقرآن الكريم في آية ثانية يحرّم بشكل عام زواج الابن من زوجة أبيه حتى لو لم تكن إرثاً وأرادا الزواج من بعضهما طوعاً حيث يقول:
( وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ) (2) .
وألغى القرآن الكريم كل عادة تستوجب تضييع مهر النساء، ومن جملتها أنّ الرجل كان حين يفقد ميله إلى زوجته فإنّه يضايقها ويؤذيها قاصداً بأذيّتها أن ترضى بالطلاق وتعيد إليه كلاًّ أو قسماً ممّا كان قد وهبها من المهر، يقول القرآن الكريم:( وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ) (3).
ومن هذه العادات - أيضاً - أنّ رجلاً مثلاً يتزوج من امرأة ويجعل لها مهراً غالياً، وحين يملّها ويشتاق إلى الزواج من أخرى، يتهم الأُولى بالفحشاء ويلوّث سمعتها ويدّعي - لذلك - أنّ هذه المرأة لم تكن لائقة
____________________
(1) سورة النساء، الآية 19.
(2) سورة النساء، الآية 22.
(3) سورة النساء، الآية 19.
بالزواج منه أصلاً ويجب فسخ عقد الزواج، ويطالب باستعادة قيمة المهر الذي وهبه لها عند الزواج، وقد ألغى القرآن الكريم هذه العادة ومنعها.
نظام المهر الإسلامي مختص بالإسلام
من مسلّمات الدين الإسلامي أنّ الرجل لا حق له في مال المرأة ولا عملها. فلا يمكن أن يأمرها بالقيام بعمل ما، وإذا ما اشتغلت المرأة وحصلت على مال نتيجة شغلها فليس للرجل حق التصرّف فيه بدون رضاها، ومن هذه الناحية يتساوى وضع المرأة والرجل. وعلى خلاف العادة المتّبعة في أوروبا المسيحية حتى أوائل القرن العشرين، فالمرأة المتزوّجة في نظر الإسلام ليست تحت قيمومة الرجل في معاملاتها وعلاقاتها الحقوقية، بل لها استقلال وحرية كاملة في إنجاز معاملاتها. والإسلام في الوقت الذي منح الزوجة مثل هذا الاستقلال الاقتصادي في مقابل الزوج ولم يجعل للزوج حقّاً في مالها ولا عملها ولا معاملاتها، لم يلغ نظام المهر. وهذا نفسه يدل على أنّ المهر في نظر الإسلام لم يكن من أجل أن يفيد الرجل بعد ذلك من وجود الزوجة اقتصادياً ويستغل إمكاناتها البدنية؛ إذاً فللإسلام نظام خاص بالمهر، وهذا النظام المهري وفلسفته يجب ألاّ يقرنا بنظم المهر الأخرى، وأنّ الاعتراضات الواردة على نظم المهر الأخرى ليست واردة على النظام الإسلامي.
قانون الفطرة
كما قلنا في المقالة السابقة، يصرّح القرآن الكريم أنّ المهر (نِحْلة) وعطية، والقرآن يعتبر هذه العطية أو الهدية شرطاً؛ لأنّه يراعي بدقّة كاملة رموز الفطرة الإنسانية، ولأنّ كلاًّ من المرأة والرجل قد عهد إليه بدور خاص في الطبيعة من حيث علاقات الصداقة؛ لذلك لم ينس أن يؤكّد شرط المهر.
دور المرأة أن تستجيب لحب الرجل، وحب المرأة سليم حين يكون ردّ فعلٍ لحب الرجل لا مبادرة منها، أمّا العشق الذي يبدأ من المرأة - أي الذي تبادر به فتعشق الرجل قبل أن يكون هو الذي بدأ بذلك - فسيواجه فشل الحب وفشل شخصية المرأة ذاتها، على خلاف الحب الذي يأتي جواباً من المرأة على حب آخر، فمثل هذا الحب لا يفشل ولا يسيء لشخصية المرأة.
هل حقّاً إنّ المرأة عديمة الوفاء؟ وأنّ عهد حبّها واهٍ؟ وأنّ حبّها لا يركن إليه؟
هذا الرأي صادق وكاذب في آن واحد. هو صادق حين يبدأ الحب من المرأة فإنّها إذا بادرت الرجل بالحب والعشق وتعلّق قلبها به، فسرعان ما تخبو نار هذا العشق، فلا يمكن الركون إلى مثل هذا الحب. وهو كاذب حين يكون الحب المتأجّج للمرأة ردّ فعلٍ للحب الصادق من قبل الرجل وجواباً للحب الحقيقي لديه. مثل هذا الحب يستبعد أن يفسخ، إلاّ إذا برد حب الرجل نفسه، فحينها ينتهي حب المرأة، والحب
الفطري للمرأة هو هذا النوع من الحب.
واشتهار المرأة بعدم الوفاء إنّما يحدث في النوع الأول من الحب. والامتنان الذي حصل نتيجة وفاء المرأة مرتبط بالنوع الثاني منه، والمجتمع إذا أراد لروابط الزوجية أن تستحكم، فلا مفرّ من أن يسلك نفس سبيل القرآن؛ وذلك مراعاة لقوانين الفطرة، ومن جملتها: أن يأخذ بنظر الاعتبار الدور الخاص لكل من المرأة والرجل في مسألة الحب، فقانون المهر انسجام مع الطبيعة من حيث إنّه دليل على ابتداء الحب من جانب الرجل، وما المرأة إلاّ مستجيبة لحبّه. والرجل لا يقدّم لها هذه الهدية والمهر إلاّ بدافع الاحترام؛ وعلى هذا الأساس يجب أن لا نلغي مادة في هذا القانون العام - الذي دوّنته يد مقنّن الطبيعة - باسم المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل.
وكما لاحظتم فإنّ القرآن في باب المهر قد غيّر العادات والقوانين الجاهلية بالرغم من ميل الرجال آنذاك إليها. فما أقرّه القرآن في باب المهر لم يكن هو العادة التي كانت سائدة في الجاهلية، لكي نقول أنّ القرآن لم يهتم بوجود المهر أو عدمه، فالقرآن كان يمكن أن يلغي المهر كليّاً ويريح الرجال من هذه الناحية لكنّه لم يفعل.
انتقادات
والآن وقد اطلعتم على وجهة نظر الإسلام حول المهر، ووضحت فلسفته فيه، فيستحسن أن تسمعوا أقوال الذين ينتقدون هذا القانون
الإلهي.
كتبت السيدة منوجهريان في كتابها: (انتقاد قوانين إيران الأساسية والمدنية)(1) في فصل بعنوان (المهر) ما ترجمته: (كما يدفع الرجل مبلغاً من المال ليحوز بستاناً أو داراً أو حصاناً أو بغلاً، كذلك يجب أن يخرج من جيبه نقوداً لأجل شراء الزوجة، وكما يتفاوت سعر الدار والبستان والبغل حسب الكبر والصغر والقبح والجمال والمنفعة والاستعمال، كذلك يتفاوت سعر الزوجة حسب القبح والجمال والغنى والفقر.
وقد كتب مشرعونا ذوو الشهامة والشفقة ما يقرب من اثنتي عشرة مادة حول سعر الزوجة، وفلسفتهم في ذلك أنّ النقود إذا لم تدخل في الموضوع فإنّ حبل الزواج المتين سرعان ما يرتخي ثم ينقطع).
لو أنّ قانون المهر قد جاء به الأجنبي، كان سيرد أيضاً هذا المقدار من التهم والافتراءات والنظرة المتحيّزة؟ وهل النقود التي يهبها أحدهما للآخر تعني أنّه يريد أنّه يشتريه؟ فعلى هذا يجب أن تلغى عادة الهدية والهبة والعطية. إنّ مصدر قانون المهر الذي جاء في القانون المدني هو القرآن. والقرآن يصرّح أنّ المهر لا عنوان له سوى الهدية والهبة. إضافة إلى أنّ الإسلام قد صاغ قوانينه الاقتصادية بصورة لا تعطي للرجل الحق في أن يستثمر المرأة اقتصادياً. يوصف المهر حينئذٍ بأنّه سعر للزوجة. يمكن أن تقولوا إنّ رجال إيران يفيدون - فعلاً - من المرأة اقتصادياً وأنا
____________________
(1) بالفارسية (انتقاد بر قوانين أساسي ومدني إيران).
أيضاً اعترف أنّ كثيراً من الرجال الإيرانيين على هذه الصورة، ولكن ما علاقة ذلك بالمهر، فالرجال يقولون لما دفعناه من مهر، يجب أن نتحكّم في نسائنا، فتحكّم الرجل الإيراني بالمرأة الإيرانية له جذور أخرى. فلماذا تريدون تخريب قانون الفطرة وتزيدون في المفاسد بدلاً من إصلاح المجتمع؟ وأنّ لكم في كل هذه الآمال قصداً آخر - غير خافٍ على أحد - هو أنّ الإيراني والشرقي يجب أن ينسى نفسه وفلسفة حياته ومعاييره الإنسانية، ويتخذ لنفسه لوناً وشكلاً أجنبيين كي يسهل ابتلاعه.
تقول السيدة منوجهريان: (إذا كانت المرأة كالرجل اقتصادياً، فما الحاجة إذا ننفق عليها ونكسوها ونجعل لها مهراً. فكما أنّ مثل هذه الاحتياجات والضمانات لا ترد بخصوص الرجل، كذلك عندها لن ترد بخصوص المرأة).
لو أردنا أن ننعم النظر جيداً في هذا الحديث لاتضح المعنى الحقيقي له كما يلي:
في المراحل التي لم يكونوا يقرون فيها بحق التملّك والاستقلال الاقتصادي للمرأة يمكن تعليل وجود المهر والنفقة، ولكن إذا منحت المرأة، استقلالاً اقتصادياً - كما حصل في الإسلام - فلا موجب حينئذٍ
لوجود النفقة والمهر. إنّها تتصوّر(1) أنّ فلسفة المهر منحصرة في إيصال النقود إلى المرأة مقابل سلب حقوقها الاقتصادية، ألم يكن من الأفضل لها أن تراجع باختصار آيات القرآن الكريم، وتتأمّل قليلاً في التعبيرات التي استعملها للمهر فتدرك فلسفته الرئيسة؛ وعندها ستفخر بما يتضمّنه كتاب أُمّتها السماوي من منطق رفيع؟
وكاتب الأربعين اقتراحاً في العدد 89 من مجلة (امرأة اليوم) صفحة 71 بعد الإشارة إلى الوضع البائس للمرأة في الجاهلية وخدمات الإسلام في هذا الباب، يكتب: (لما كانت المرأة والرجل قد خلقا متساويين فإنّ بذل ثمن أو أجرة من أحدهما للآخر ليس له سبب معقول، فكما أنّ الرجل محتاج إلى المرأة، كذلك المرأة محتاجة إلى وجود الرجل، وقد خلقهما الرب محتاجين إلى بعضهما، وهما في هذا الاحتياج متساويان مع بعضهما، وعليه فإنّ إلزام احدهما بدفع مالٍ إلى الآخر يفتقر إلى التعليل، ولكن لما كان الطلاق بيد الرجل، وليس للمرأة ضمانة في حياتها المشتركة معه، فقد أُعطي للمرأة - علاوة على مسألة الثقة بالزواج - حق المطالبة بوثيقة مالية من الرجل).
وفي صفحة 72 يقول: (لو أنّ المادة 1133 من القانون المدني التي تقرّر أنّ: (للرجل في أيّ وقت يشاءان يطلق زوجته) عدلت ولم يربط الطلاق بميل الرجل وهوسه، فسيفقد الصداق والمهر أساساً مبرّر
____________________
(1) أي السيدة منوجهريان.
وجوده).
وما تحدثنا به لحد الآن يغني عن توضيح هذه المطالب أكثر، فقد وضّح أنّ المهر ليس ثمناً أو أجرة، كما أنّ لوجوده سبباً منطقياً، ووضّح أيضاً أنّ المرأة والرجل في احتياجهما لبعضهما غير متساويين، وأنّ الخالق قد وضع كلاًّ منهما في وضع يختلف عن الآخر.
والأوهى من كل ما مر القول بأنّ المهر ضمانة مالية في مقابل إناطة حق الطلاق بالرجل، والادعاء بأنّ الإسلام أقرّ المهر من هذا المنطلق.
ولنسأل مثل هؤلاء الأشخاص: لماذا أعطى الإسلام حق الطلاق للرجل لكي يوجد الحاجة إلى ضمانة مالية بيد المرأة، وأكثر من هذا فإنّ معنى هذا الكلام هو ما يلي: أنّ الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله) قد جعل لنسائه مهراً لأنّه أراد أن يكون لهنّ عليه ضمانة مالية، وأنّه في زواج علي وفاطمة (عليه السلام) قد جعل لفاطمة (عليه السلام) مهراً من أجل أن تكون لها ضمانة مالية في مقابل علي (عليه السلام) ويطمئن قلبها. إذا كان الأمر كذلك، فلماذا حث النبي الأكرم (صلّى الله عليه وآله) النساء على أن يبيّن مهورهن لأزواجهن وذكر أنّ لهذه الهبات ثواباً عظيماً؟ وأكثر من ذلك، لِم حثّ على أن يكون مهر النساء قليلاً؟ أفلا يكون غرض نبي الإسلام أنّ هديّة الرجل في الزواج باسم المهر وهبة المهر، أو ما يعادله من قبل المرأة لزوجها ممّا يقوّي عرى الأُلفة والمحبّة في الزواج؟
وإذا كان غرض الإسلام أن يكون المهر ضمانة مالية، فلم جاء في كتابه السماوي قوله تعالى:( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) ، ولم يقل:
(وآتوا النساء صدقاتهن ضمانة)؟
وعدا عن كل ذلك، فإنّ الكاتب المذكور تصوّر أنّ عادة المهر في صدر الإسلام كانت على ما هي عليه اليوم؛ إذ مهر هذه الأيام له جانب يتعلّق بالذمّة والعهد، أي أنّ الرجل يتعهّد بمبلغ من المال طبق عقد أو سند ولا تطالب به المرأة عادة إلاّ إذا حصل خلاف وشجار، هذا النوع من المهر يتخذ حقيقة صورة وثيقة الضمان. أمّا في صدر الإسلام فقد كان الرجل يدفع نقداً ما يتعهّد به من مهر؛ ولهذا، فلا يمكن القول إطلاقاً أنّ المهر من وجهة نظر الإسلام كان وثيقة تتسلّمها المرأة.
ويرينا التاريخ أنّ الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله) لم يكن يوافق - بأيّ وجه من الوجوه - على أن يزوّج امرأة من رجل بدون مهر. وقد وردت قصة باختلاف بسيط في كتب الشيعة والسنّة على الوجه التالي:
جاءت امرأة إلى النبي الأكرم (صلّى الله عليه وآله) فوقفت بين الحاضرين وقالت:
- يا رسول الله اتخذني زوجة.
* سكت الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله) أمام طلب المرأة، ولم يقل شيئاً، وجلست المرأة في مكانها. فقام رجل من الصحابة وقال: يا رسول الله، إذا لم تكن راغباً في ذلك، فأنا لها.
* سأله الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله) قائلاً: ماذا جعلت لها من مهر؟
- ليس عندي شيء
* لا يصح هكذا، اذهب إلى دارك عسى أن تجد شيئاً تعطيه لها مهراً.
ذهب الرجل إلى داره ثم عاد يقول: لم أجد في داري شيئاً.
* عد وفتّش ثانية وحتى لو جئت بخاتم من حديد فهو كافٍ.
فذهب ثم عاد قائلاً: (لم أجد في داري حتى خاتم حديد وإنّني على استعداد أن أجعل ثوبي الذي ألبسه الآن مهراً لهذه المرأة.
فقال أحد الصحابة وكان يعرف الرجل: يا رسول الله. والله إنّ هذا الرجل لا يملك ثوباً غيره. فاجعل نصف هذا الثوب مهراً للمرأة.
قال الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله) إذا صار نصف الثوب مهراً للمرأة فأيّهما يرتديه؟ وأيّهما ارتداه، بقي الثاني بدون لباس، كلاّ لا يصح هكذا.
وجلس الخاطب في مكانه. وكانت المرأة تنتظر جالسة في مكانها. وجرى الحديث في مواضيع أخرى وطال. ونهض الرجل ليذهب فناداه الرسول (صلّى الله عليه وآله) قائلاً: اقترب.
* وعندما اقترب سأله الرسول (صلّى الله عليه وآله): هل تعرف شيئاً من القرآن؟
- بلى، يا رسول الله، أعرف كذا وكذا من السور.
* هل تستطيع القراءة عن حفظ؟
- بلى أستطيع.
* حسناً، حُلّت المشكلة، إذاً فقد زوّجتك هذه المرأة، ومهرها أن تعلّمها القرآن، فأخذ الرجل يد عروسه وخرج.
وفي باب المهر مطالب أخرى، لكنّني أكتفي بهذا القدر.
(3) المهر والنفقة
بيّنا وجهة نظر الإسلام حول المهر وفلسفته، والآن جاء دور النفقة لنبحثها.
يجب أن نعلم أولاً أنّ في القوانين الإسلامية للنفقة - كما للمهر - وضعاً خاصاً يمكن النظر إليه كما ينظر إلى ما وضع أو يوضع من قوانين في العالم غير الإسلامي.
ولو كان الإسلام قد أعطى الرجل حق استخدام المرأة ثم مصادرة ما تحصل عليه من مال لقاء عملها، لكانت فلسفة إنفاق الرجل على المرأة واضحة، إذ من البديهي أنّ أيّ إنسانٍ يستخدم حيواناً أو إنساناً آخر ليفيد منه اقتصادياً، يتوجّب عليه تأمين احتياجات ومتطلّبات حياة ذلك المستخدم الحياتية. ولو لم يطعم الحوذي حصانه التبن والشعير، لما كان بإمكان الحصان أن يجرّ له العربة المحمّلة بالأثقال.
لكنّ الإسلام لا يرى للرجل مثل هذا الحق، بل أعطى المرأة الحق في أن تملك، وأن تكسب المال، ولم يجعل للرجل حق التصرّف في ثرواتها بل اشترط على الرجل - في نفس الوقت - أن يؤمّن مصرف العائلة، ونفقات الزوجة والأولاد والخادم والمسكن ومختلف المصاريف. فلماذا كان ذلك؟ ممّا يؤسف له أنّ مقلّدي الغرب عندنا غير مستعدّين إطلاقاً للتفكير قليلاً في هذه الأمور، بل غضّوا الطرف، وتناولوا الانتقادات التي يوردها الغربيون حول نظمهم الحقوقية - وهي
صحيحة طبعاً - وصاروا يوردونها بشأن نظام الحقوق الإسلامي.
وفي الواقع لو قال شخص إنّ نفقة المرأة في الغرب حتى القرن التاسع عشر لم تكن شيئاً غير أجرة وشارة للعبودية، فقد أصاب؛ لأنّ المرأة حين تكون مكلّفة بإدارة الحياة الداخلية للرجل مجاناً، ولا يكون لها حق التملّك؛ فالنفقة التي تدفع لها هي من جنس الأجرة التي تدفع للأسير أو العلف الذي يوضع أمام حيوانات جرّ الأثقال. أمّا إذا وجدنا في العالم قانوناً متميّزاً يرفع عن كاهل المرأة عبء إدارة الحياة الداخلية للرجل كشرط واجب، ويمنحها حق كسب المال والاستقلال الاقتصادي الكامل، ويعفيها في الوقت ذاته من المشاركة في ميزانية الأُسرة، لابدّ أنّه قد أخذ بنظر الاعتبار فلسفة أخرى يجب التأمّل في جوانبها.
حجر المرأة الغربية
حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر
ورد في شرح القانون المدني الإيراني ما يلي:
(إنّ الاستقلال الذي تتمتّع به المرأة في أموالها، والذي أقرّه فقه الشيعة منذ البداية لم يكن موجوداً في لوائح حقوق اليونان والرومان واليابانيين، ولا حتى وقت قريب في لوائح حقوق أغلب الدول، فالمرأة عندهم كالصغير والمجنون محجور عليها وممنوعة من التصرّف في أموالها. ففي انكلترا - حيث كانت شخصية المرأة سابقاً ذائبة تماماً في
شخصية زوجها، شُرّع قانونان، الأوّل في عام 1870، والثاني في عام 1882م باسم قانون ملكية المتزوجة رفع الحجر بمقتضاهما عن المرأة. وفي إيطاليا كان قانون 1919م هو الذي أخرج المرأة من عداد المحجور عليهم. وفي قانون ألمانيا المدني لعام 1900م وقانون سويسرا المدني لعام 1907م أصبح للزوجة مثل حقوق زوجها. لكن المرأة المتزوجة في قانون حقوق البرتغال وفرنسا ما تزال في عداد المحجور عليهم. ويقال إن قانون 18 شباط 1938م في فرنسا عدل حدود الحجر على المتزوجة)(1) .
وكما تلاحظون، لم يمض قرن واحد على صدور أوّل قانون استقلال مالي للزوجة مقابل الزوج (1882م في انكلترا) في أوروبا أي ما يسمّى برفع الحجر عنها.
لماذا أعطت أوروبا المرأة الاستقلال المالي فجأة؟
والآن كيف وقعت هذه الحادثة المهمّة قبل قرن؟ هل ثارت المشاعر الإنسانية لدى رجال أوروبا وأدركوا ظلمهم السابق.
الجواب نسمعه من (ويل ديورانت). فقد خصّص في (لذات الفلسفة) صفحة 158 بحثاً تحت عنوان (الأسباب) يشرح فيه ما يسمّى أسباب تحرير المرأة في أوروبا. وهنا نصطدم - للأسف - بحقيقة مفزعة؛
____________________
(1) بالفارسية (قانون مدني إيران)، دكتور شايغان، ص 260.
إذ يتضح أنّ المرأة الأوروبية في مقابل الحرية وحق الملكية يجب أن تشكر الآلة لا الإنسان، ويجب أن تنحني تعظيماً أمام العجلات العظيمة للآلة لا أمام رجال أوروبا. فطمع أصحاب المعامل وفرصهم على كسب أرباح أكثر ودفع أجور أقل هو الذي دعاهم إلى تشريع قانون الاستقلال الاقتصادي في البرلمان البريطاني.
يقول ويل ديورانت: (كيف نعلّل هذا التحوّل السريع في العادات والتقاليد المحترمة والسابقة لتاريخ المسيحية؟ إن السبب لهذا التغيير الكلّي هو وفرة وتعدّد الآلات، أمّا (تحرير) المرأة فهو ناتج عن الثورة الصناعية...
* في انكلترا قبل قرن أصبح العثور على عمل صعباً على الرجال. والإعلانات كانت تطلب منهم إرسال نسائهم وأطفالهم إلى المعامل، فأصحاب الأعمال يجب أن يفكروا في الربح والأسهم، ويجب أن لا يكدّروا خواطرهم بأخلاق وعادات الحكومات، وأنّ الأشخاص الذين تآمروا فجأة على سلامة البيت كانوا أصحاب المعامل الذين هم وطنيو القرن التاسع عشر.
* في انجلترا كانت أوّل خطوة لتحرير جدّاتنا هي قانون 1882م، بموجب هذا القانون أصبحت نساء بريطانيا العظمى من الآن فصاعداً تتمتّع بميزة لم يسبق لها مثيل هي أنّ لهنّ الحق بالاحتفاظ بالنقود التي يكتسبنها لأنفسهن، هذا القانون الأخلاقي والمسيحي الرفيع قد وضعه
أصحاب المعامل في مجلس العموم البريطاني من أجل أن يتمكنوا من اجتذاب نساء انكلترا إلى المعامل، ومنذ ذلك العام وحتى عامنا هذا حرّر الربح الذي لا يقاوم هؤلاء النساء من العبودية والعذاب داخل البيت ليصبحن رهن العبودية والعذاب في المتاجر والمعامل).
وكما تلاحظون أنّ الرأسماليين وأصحاب المعامل في انجلترا - ومن أجل المصالح المادية - قد خطوا هذه الخطوة في سبيل المرأة.
القرآن والاستقلال الاقتصادي للمرأة
وضع الإسلام هذا القانون قبل ألف وأربعمئة عام فقال:
( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ) (1) .
فالقرآن المجيد في هذه الآية الكريمة كما اعترف بحق الرجال في ثمرات أعمالهم ونشاطاتهم، كذلك اعتبر النساء ذوات حق في ثمرات أعمالهن ونشاطاتهن.
وجاء في آية أُخرى:
( لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ ) (2) .
هذه الآية تثبت للمرأة حق الإرث، إما أن ترث المرأة أو لا ترث
____________________
(1) سورة النساء، الآية 32.
(2) سورة النساء، الآية 7.
فأمر له تاريخ مفصّل سنذكره فيما بعد إن شاء الله؛ إذ لم يكن عرب الجاهلية يسمحون للمرأة أن ترث. أمّا القرآن الكريم فقد ثبّت للمرأة هذا الحق.
مقارنة
إذاً فقد منح القرآن الكريم المرأة استقلالها الاقتصادي قبل أوروبا بثلاثة عشر قرناً، مع الاختلافات التالية:
أولاً: إنّ الدافع الذي حدا بالإسلام أن يمنح المرأة استقلالها الاقتصادي لم يكن سوى الجانب الإنساني وحب العدالة الإلهية في الإسلام. إذ لم تكن وقتها أطماع أصحاب المعامل الانجليز الذين سنّوا هذا القانون من أجل ملء بطونهم، ثم ملأوا الدنيا ضجيجا بقولهم: (إنّنا قد اعترفنا بحق المرأة وساوينا بينها وبين الرجل في الحقوق).
ثانياً: منح الإسلام للمرأة استقلالها الاقتصادي، لكنّه - حسب تعبير ويل ديورانت - لم يهدّ البيوت، ولم يزلزل أساس العائلة، ولم يحرّض النساء والفتيات على التمرّد على الأزواج والآباء؛ فهو قد أوجد بهاتين الآيتين ثورة اجتماعية عظيمة، لكن بهدوء وبدون ضرر أو خطر.
ثالثاً: إنّ ما فعله عالم الغرب كان كما ذكر (ويل ديورانت) هو تحرير المرأة من العبودية والعذاب في البيت، وجعلها رهينة العبودية والعذاب في المتجر والمعمل. أي إنّ أوروبا فكّت عن يدي المرأة وساقيها قيداً واستبدلت به قيداً آخر لا يقل عن الأول قساوة، أمّا الإسلام فقد حرّر
المرأة من استعباد الرجل في البيت والمزرعة وغير ذلك، وبإلزام الرجل بتأمين ميزانية المجتمع الأُسري؛ رفع عن كاهل المرأة كل إلزام حول تأمين مصروفاتها ومصروفات الأسرة.
إنّ الإسلام أعطى المرأة حقّها في اكتساب الثروة وتنميتها كما تقتضيه الغريزة، ولكن ليس بالشكل الذي يسمح لضرورات المعيشة أن تسلبها جمالها ولطافتها حيث ينبغي أن تتوفّر عليهما دائماً. ولكن ما العمل؟ وعيون وآذان بعض كتّابنا مغلقة عن الحقائق التاريخية والفلسفية المسلمة.
نقد ورد
السيدة منوجهريان في كتاب (انتقاد على قوانين إيران الأساسية والمدنية) صفحة 37 كتبت ما يلي: (قانوننا المدني - من جهة - يلزم الرجل بالنفقة على زوجته، أي أن يهيئ: اللباس، والطعام، والمسكن، فكما أن مالك الحصان والبغل ملزم بتوفير الطعام والمسكن لهما، كذلك يجب على مالك المرأة أن يضع في متناولها هذا الحد الأدنى من المعيشة. ولكن - من جهة ثانية - لا ندري لماذا تقرّر المادة (1110) من القانون المدني عدم استحقاق المرأة للنفقة خلال عدّة الوفاء بينما هي أحوج ما تكون - والحال هذه - إلى التسلية والملاطفة، ولا يجوز عند فقدها لمالكها أن تبقى رهينة الهم واضطراب الفكر. من الممكن أن تقولوا في أنّك أنت التي تنادين بتحرير المرأة وتطالبين بمساواتها
بالرجل في كل مكان، لماذا تريدين هنا أيضاً أن تبقى المرأة أمَة وأجيرة وتابعة للرجل وتنتظر أن تستمر هذه العبودية والأسر حتى بعد موته. ونحن نجيب بأنّه طبقاً لفسلفة استعباد المرأة الذي شُرّع على أساسها هذا القانون، كان من الأفضل لمالكي رقبة المرأة - على حد قول سعدي - أن يوصوا بالإنفاق على المرأة بعد وفاتهم، وأن يراعي القانون هذا الجانب كذلك).
ونحن نسأل الكاتبة:
أوّلاً: أي موضع من القانون المدني وأي موضع من القانون الإسلامي (أو كما تسمّيها فلسفة استعباد المرأة) استنبطت منه أنّ الرجل مالك المرأة، وأنّ علّة دفع النفقة من قِبل الرجل هو تملّك للمرأة؟ أي مالك هذا الذي لا يحق له أن يقول لمملوكه: ناولني كأس ماء؟ أي مالك هذا الذي يكون كسب مملوكه ملكاً للمملوك لا له؟ أي مالك هذا الذي يحق لمملوكه كلّما قدم له خدمة صغيرة - لو رضي المملوك بتقديمها - أن يطالبه بأجرة عليها؟ أي مالك هذا الذي لا يحق له أن يفرض على مملوكه أن يرضع - مجاناً - طفله الذي وُلد في بيته؟
ثانياً: هل إنّ كل مَن يقبل نفقة شخص يصبح مملوكاً له؟ فمن وجهة نظر الإسلام - وكل قوانين العالم - يعتبر إنفاق الأب والأم على أولادهما واجباً. فهل يعد هذا دليلاً على أنّ جميع قوانين العالم تعتبر الأولاد مماليك للآباء؟ وفي الإسلام إذا كان الأب والأم فقيرين فإنّ
نفقتهما واجبة على الولد دون أن يفرض عليهما ولدهما شيئاً، فهل يمكن أن نقول إنّ الإسلام يعتبر الآباء والأُمّهات مماليك لأولادهم؟
ثالثاً: والأعجب من هذا كلّه قولها: لماذا لا تجب نفقة المرأة على زوجها في عدّة وفاته في وقت هي أحوج ما تكون إلى ماله؟
كأنّ الكاتبة الكريمة تعيش في أوروبا ما قبل مئة عام.
ملاك إعطاء النفقة للزوجة ليس حاجة الزوجة، فلو لم يكن للمرأة ففي نظر الإسلام - في الفترة التي تحياها مع زوجها - حق الملكية؛ لكان هذا المطلب سليماً، إذ يختل وضعها بعد وفاة الزوج مباشرة، ولكن ما الداعي للقانون - الذي منح المرأة حق التملّك وكانت النساء في ظلّه يحتفظن بأموالهن بسبب تأمين احتياجاتهن من قبل الزواج - إلى إيجاب النفقة إلى مدّة انحلال عرى الزوجية؟ النفقة هي حق حفظ عش الزوجية جميلاً نظيفاً سالماً لكن لا داعي لاستمرار هذا الحق بعد خراب ذلك العش.
ثلاثة أنواع من النفقة
توجد في الإسلام ثلاثة أنواع من النفقة:
الأوّل: النفقة التي يجب أن يبذلها المالك للمملوك.
فالمصروفات التي يبذلها مالك الحيوانات لها هي من هذا القبيل، ملاك هذا النوع من النفقة هو المالكية والمملوكية.
الثاني: النفقة التي يجب أن يبذلها المرء لأولاده إذا كانوا صغاراً أو فقراء، والتي يبذلها لأبيه وأُمّه إذا كانا فقيرين. ملاك هذا النوع من النفقة ليس المالكية والمملوكية، وإنّما الحق الذي يحصل عليه الأولاد طبيعة من والديهم والحق الذي يكون للوالدين على أولادهم بحكم اشتراكهم في الإتيان بالولد إلى هذه الدنيا وتحمّلهم المتاعب من أجله أيام طفولته. شرط هذا النوع من النفقة هو ضعف وفقر الشخص واجب النفقة.
الثالث: النفقة التي يبذلها الرجل لزوجته. ملاك هذا النوع من النفقة ليس المالكية والمملوكية، ولا الحق الطبيعي بالمفهوم الذي ذكر في النوع الثاني، ولا عجز وضعف وفقر المرأة.
فلو فرضنا أنّ المرأة كانت مليونيرة وتتمتّع بمورد مالي ضخم، والرجل قليل الثروة ضعيف المورد، مع ذلك فالرجل هو الذي يجب أن يؤمّن ميزانية الأسرة وبضمنها ميزانية المرأة الشخصية. فرق آخر بين هذا النوع من النفقة وبين النوعين الأولين، وهو أنّ الشخص المنفق إذا أهمل واجبه في النوعين الأوّلين ولم يعط النفقة فهو آثم، لكنّ إهماله لواجبه لا يمكن صياغته بصورة دين مقابل المطالبة والاستيفاء، وبتعبيرٍ آخر: ليس له جانب حقوقي. لكن في النوع الثالث إذا أهمل الزوج واجبه ولم ينفق فللزوجة الحق في إقامة الدعوى عليه بشكل قضية حقوقية، وفي حال ثبوت التقصير، يلزم بتسليمها المال. أمّا ما هو ملاك هذا النوع من النفقة فهذا ما سنبحثه في الفصل القادم إن شاء الله.
ألا تريد المرأة اليوم المهر والنفقة
قلنا إنّه - من وجهة نظر الإسلام - يجب على الرجل تأمين ميزانية المؤسسة الأُسرية، ومن جملتها المصاريف الشخصية للمرأة، وليس على المرأة أيّة مسؤولية من هذه الناحية. فلو فرضنا أنّ للمرأة ثروة ضخمة تزيد عدّة أضعاف على ما يملكه الزوج، فليست ملزمة بالمشاركة في ميزانية الأسرة. ومشاركتها في الميزانية، سواء من حيث المال الذي تريد إنفاقه أو من حيث العمل الذي يحتاج إلى نفقة، تابع لإرادتها ورغبتها واختيارها.
من وجهة نظر الإسلام، بالرغم من أنّ مصاريف معيشة الزوجة تشكّل جزءاً من ميزانية الأسرة - وهي من واجبات الرجل - إلاّ أنّ الرجل ليس له أي تسلّط اقتصادي على المرأة ولا حقّ له في استثمار طاقتها وعملها، وليس له أن يستغلّها فنفقة المرأة من هذه الناحية تشبه نفقة الوالدين من حيث تجب على الولد في موارد خاصة، فلا يكون للولد - في مقابل هذا الواجب الذي يؤدّيه - أن يستخدم والديه.
مراعاة جانب المرأة في الأُمور المالية
التزم الإسلام - بشكل لا سابقة له - جانب المرأة في الأمور المالية والاقتصادية، فهو من جهة قد منح المرأة الاستقلال والحرية الاقتصادية الكاملة وكفّ يد الرجل عن مالها وعملها، واستعاد لها منه حق القيمومة في معاملاتها - والذي كان بيد الرجل في العالم القديم وفي أوروبا حتى
أوائل القرن العشرين - ومن جهة أخرى أزال مسؤولية تأمين ميزانية الأُسرة عن كاهلها، وأراحها من السعي لتأمين المال اللازم لتأمين ميزانية الأسرة.
لكن عبّاد الغرب حين أرادوا أن ينتقدوا هذا القانون باسم الدفاع عن المرأة، لم يجدوا طريقة غير الكذب المفضوح والافتراء المضحك، قالوا: فلسفة النفقة هي أنّ الرجل يعتبر المرأة ملكه ويستغلّها لخدمته، فكما أنّ مالك الحيوان مضطر لتأمين احتياجات حيواناته الضرورية كي تتمكّن هذه الحيوانات من أن تؤمّن له المركب وتنقل له الأحمال، كذلك قانون النفقة أوجب - بهذا القصد - توفير عيش الكفاف للمرأة.
فلو أنّ شخصاً هاجم قانون الإسلام بعنوان أنّه بالغ في تدليل المرأة، بينما قسا على الرجل وجعل منه خادماً بالمجّان للمرأة، لكان في اعتراضه مجال للأخذ والرد أكثر ممّا لو اعترض على القانون باسم المرأة والدفاع عنها.
والحقيقة أنّ الإسلام لم يكن يريد ان يضع قانونا لمصلحة المرأة ضد الرجل ولا لمصلحة الرجل ضد المرأة. الاسلام لايتحيز للمرأة ولا يتحيز للرجل. فهو في قوانينه انما اخذ بنظر الاعتبار سعادة الرجل والمرأة والاولاد الذين سيتربون في كنفهما وبالنتيجة سعادة المجتمع الانساني. يرى الاسلام طريق السعادة للمرأة والرجل والاولاد والمجتمع الانساني فى عدم تجاهل القواعد والقوانين الطبيعية والنظم
التي وضعتها يد الخالق القدير المدبر.
وكما ذكرنا مراراً، فإنّ الإسلام قد راعى في قوانينه قاعدةً هي أنّ الرجل يمثل الاحتياج، والمرأة تمثّل الاستغناء، هو يرى الرجل في صورة المشتري والمرأة في صورة صاحب البضاعة، والإسلام ينظر إلى الرجل - في حياته الجنسية والمشتركة مع زوجته - أنّه هو المستفيد، وأنّه يجب أن يتحمّل النفقات، ويجب أن لا تنسى المرأة والرجل أنّهما في مسألة الحب في نظر الطبيعة ذوا دورين متباينين. فالرابطة الزوجية حين تكون ثابتة قوية تكون ممتعة ويظهر كل من المرأة والرجل دوره الطبيعي فيها.
والسبب الآخر لوضع نفقة الزوجة بعهدة الزوج هو أنّ الطبيعة وضعت على عاتق المرأة مسؤولية تعب ومعاناة عملية إنتاج النسل، إذ إنّ مسؤولية الرجل من حيث الطبيعة في هذا الجانب ليست إلاّ عملاً ملذاً آنياً، والمرأة هي التي تعاني من مصاعب وآلام الدورة الشهرية (الحيض) عدا أمراض الطفولة والكهولة وثقل الحمل وأعراضه وصعوبة الولادة وعوارضها، وإرضاع الطفل ورعايته. فهذا كلّه ممّا يرهق قوّتها البدنية، ويضعف قدرتها على العمل والكسب؛ ولهذا فإنّ القانون إذا عامل المرأة والرجل على حدٍّ سواء في تأمين ميزانية المعيشة ولم يراع المرأة؛ تصبح المرأة مستعبدة؛ ولذا نرى في الأحياء التي تعيش بشكل زوجي أنّ الذكر يقوم بالدفاع عن الأنثى في فترة التكاثر ويساعد في
تهيئة الغذاء. وإضافة إلى المرأة والرجل لم يخلقا متشابهين من حيث طاقة العمل والنشاط العنيف في مجال الإنتاج. فلو أنّ الرجل تصرّف كأجنبي وامتنع عن الإنفاق على زوجته عناداً فستعجز المرأة عن الصمود والثبات.
والأهم من كل ما ذكرنا: هو أنّ حاجة المرأة إلى المال والثروة أكثر من حاجة الرجل، فالزينة جزء من حياة المرأة ومن حاجاتها الأساسية، وأنّ ما تنفقه على زينتها وجمالها ومظهرها يعادل ما ينفقه عدّة رجال. والميل إلى الزينة أدّى بالمرأة بدوره إلى أن تميل إلى التنوع والتفنن، فبالنسبة للرجل تبقى بدلته مناسبة للارتداء في نظره ما دامت لم تبل، ولكن هل هذا هو حال المرأة؟ إنّها تستفيد من البدلة ما دامت لم تبدو جديدة، وهي لا تستعمل البدلة أو أيّة مادة للزينة والتجميل أكثر من مرة واحدة. إنّ قدرة المرأة وسعيها من أجل كسب المال أقل من الرجل، لكن إنفاقها المال أكثر من انفاق الرجل له بمراتب.
أضف إلى ذلك أنّ المرأة تظل هي المرأة، أي أنّ دوام مالها، ونشاطها وكبرياءها تتطلّب رفاهاً أكثر وجهداً أقل وراحة نفسية أكبر. فلو اضطرّت المرأة لأن تكون مثل الرجل في الكد والسعي والركض وراء المال، فيسجرح كبرياؤها، وتعلو جبينها الأخاديد والتجاعيد التي تعلو وجه الرجل في العادة، وكثيراً ما نسمع أنّ النساء الغربيات اللواتي يعشن تعاسة المعامل والمتاجر والدوائر من أجل لقمة العيش، يتمنّين
الفوز بحياة المرأة الشرقية. وبديهي أنّ المرأة الفاقدة لراحة الذهن أن تجد فرصة العناية بنفسها أو تكون مصدر سرور الرجل وبهجته.
فإنّ إعفاء المرأة من السعي الإجباري - المنهك لقواها - من أجل لقمة العيش ليس في مصلحتها فقط، بل هو في مصلحة الرجل والمؤسسة الأُسرية أيضاً.
والرجل يتمنّى أيضاً أن تكون مؤسّسة الأُسرة بالنسبة إليه مؤسّسة راحة واستقرار بعد التعب، ومكاناً ينسى فيه مشكلات العمل. والمرأة قادرة على أن تجعل من المؤسسة البيتية محلاًّ للراحة ونسيان مشكلات العمل، حين لا تكون متعبة كالرجل إثر العمل في الخارج. ويا له من مسكين ذلك الذي يضع قدمه في البيت متعباً مكدوداً لتواجهه زوجة أكثر منه تعباً وكدّاً؛ لهذا فراحة الزوجة وسلامتها ونشاطها وصفاء ذهنها له قيمة كبيرة أيضاً بالنسبة للرجل.
والسر الذي يكمن وراء استعداد الرجل لكسب النقود بالعمل المضني، ثمن تقديمها بكلتا اليدين إلى زوجته لتنفق عن سعة هنا وهناك هو أنّ الرجل يكون قد أدرك حاجته الروحية إلى الزوجة، أدرك أن الله عزّ وجل قد جعلها مصدر الراحة وسكون الروح( وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ) . أدرك أنّه كلّما هيّأ موجبات راحة زوجته واستقرارها، فقد هيّأ أسباب السعادة لنفسه بشكل غير مباشر، وزاد في رونق بيته... أدرك أنّه يجب أن يكون أحد الزوجين على الأقل غير
متعب ولا مرهق كي يتيسّر له أن يوفّر الهدوء لروح الآخر، وعلى أساس هذا التقسيم ليس أفضل من أن يكون الرجل هو الذي يدخل معركة الحياة، وليس أفضل للمرأة من أن تكون هي باعث هدوء روح زوجها.
خلقت المرأة محتاجة مادّياً إلى الرجل والرجل محتاج إليها روحيّاً. المرأة تستطيع - بدون الاعتماد على الرجل - أن تسد حاجاتها المادية المتشعّبة والتي تعادل أضعاف حاجات الرجل، وفي هذا الجانب عيّن لها الإسلام نقطة اعتمادها ألا وهي زوجها القانوني (وزوجها القانوني فقط).
والمرأة إذا ما أرادت أن تحيا كما يحلو لها، وألاّ تعتمد في ذلك على زوجها القانوني، فستعتمد على رجال غيره، وهذا الوضع له - مع الأسف - نماذج كثيرة وآخذة بالازدياد أيضاً.
لماذا التنديد بالنفقة؟
لقد أدرك الرجال المتصيّدون هذه النقطة، ومن أسباب التنديد بوجوب إنفاق الرجل على المرأة هي أنّ المرأة كثيرة الاحتياج للمال، فإذا اعتمدت في ذلك على الزوج ثم انقطعت عنها النفقة بعد ذلك فستقع في حبائل المتصيّدين بسهولة.
ولو دقّقتم في سبب منح النساء رواتب ضخمة في مؤسسات العمل لفهمتم ما أرمي إليه. فلا تشكّوا في حقيقة أنّ فكرة إلغاء النفقة ستؤدّي حتماً إلى ازدياد الفحشاء؛ إذ كيف يمكن للمرأة التي يعزل حسابها عن
الرجل أن تحيا كما تقتضي طبيعتها؟
وإذا أردتم الحق، فإنّ فكرة النفقة قد شجّعها أيضاً الرجال الذين ضاقوا ذرعاً بإسراف النساء بوسائل الزينة ومواد التجميل، فهم يريدون أن يثأروا من الزوجات المبذرات المتبرّجات بأيدي نفس النساء باسم التحرّر والمساواة.
(ويل ديورانت) في كتابه (لذات الفلسفة) في تعريفه للزواج الحديث بأنّه: (زواج قانوني مع منع حمل قانوني وحق طلاق برضا الطرفين وعدم وجود الطفل والنفقة)، يقول: (ستكون العابدات للزينة والتجميل من الطبقة الوسطى من النساء سبباً عاجلاً لانتقام الرجل الكادح من كل النساء وسيتغيّر الزواج بشكل لا تبقى هناك نساء عاطلات لا همّ لهنّ سوى التجميل وإثقال ميزانية البيت، وسيطلب الرجال من زوجاتهم أن يقمن بتأمين مصاريفهن بأنفسهن. ويفرض زواج الصداقة (الزواج الجديد) على المرأة أن تعمل إلى أن تصبح حاملاً، وهنا نقطة مهمّة ستكون عاملاً في إكمال تحرّر المرأة، تلك هي أنّ المرأة من الآن فصاعداً ستكون المسؤولة عن تأمين مصاريفها من البداية إلى النهاية. إنّ النتائج القاسية للثورة الصناعية (فيما يخص المرأة) قد بدأت بالظهور. فالمرأة يجب أن تعمل في المصنع إلى جانب زوجها، وهي بدلاً من أن تجلس لوحدها في البيت وتجبر الرجل على العمل المضاعف من أجل تفادي بطالتها، يجب عليها الآن أن تشاركه
في العمل والأجور والحقوق والواجبات).
وهنا يضيف بسخرية: (وهذا هو معنى حرية المرأة)!
الحكومة بدل الزوج
إنّ كون الواجبات الطبيعية للمرأة في إنجاب الأطفال تحتّم أن يكون للمرأة نقطة ارتكاز من الناحية المالية والاقتصادية، أمر لا يمكن إنكاره.
ففي أوروبا اليوم أفراد وصل بهم الأمر في الدعوة إلى تحرّر المرأة حدّاً أصبحوا ينادون بالعودة إلى مرحلة (سلطة الأم) وطرد الأب من العائلة. ففي نظر هؤلاء، إنّه باستقلال المرأة استقلالها اقتصادياً كاملاً وتساويها بالرجل في الأمور سيكون الأب في المستقبل عضواً زائداً، ويجب أن يحذف من الأسرة إلى الأبد.
وفي نفس الوقت يدعو هؤلاء الأفراد الحكومة إلى أن تحل محل الأب وتمنح النساء - اللائي لم يكنّ مستعدّات مطلقاً لتشكيل الأسرة بمفردهن والقيام بجميع المسؤوليات - نقوداً، ومساعدتهن كي لا يمتنعن عن الحمل فينقطع نسل المجتمع. أي إنّ الزوجة التي كانت في السابق مستهلكة لنفقة الرجل - وعلى حد تعبير المعارضين مملوكة - ستتلقّى من الآن فصاعداً النفقة من الحكومة وتصبح مملوكة لها. وتنتقل واجبات وحقوق الأب إلى الدولة. أتمنى لو أنّ الأفراد الذين رفعوا المعول ليهدموا بطريقة عشوائية مؤسّسة الأسرة المقدّسة، التي قامت
على أساس القوانين السماوية المقدّسة، أتمنى لو أنّهم كانوا قد فكّروا في عواقب تصرّفهم هذا ونظروا إلى المدى الأبعد من الحاضر.
في كتاب (الزواج والأخلاق) خصّص (برتراند راسل) فصلاً تحت عنوان الأسرة والدولة، وهنا بعد الإشارة إلى بعض إنجازات الدولة في النواحي الثقافية والصحية للأطفال - يقول: (يظهر أنّه سوف لن يمر وقت طويل حتى يفقد الأب مقتضيات وجوده البيولوجي... وهناك عامل آخر مؤثّر في طرد الأب هو ميل النساء إلى الاستقلال المادي، فالنساء اللائي يشتركن - غالباً - في التصويت من الآنسات، ومشكلات النساء المتزوجات اليوم أكثر من مشاكل الآنسات، ومع وجود مميزات قانونية منافسة في الأعمال، تتأخّر المتزوجات في الحصول على العمل... وعلى المتزوجات سلوك أحد طريقين للحفاظ على استقلالهن الاقتصادي:
الأول: أن يبقين في أعمالهن، وهذا يستلزم أن يتركن أطفالهن في دور الحضانة مقابل أجر، ممّا يسبّب في توسّع وازدياد دور الحضانة ورياض الأطفال زيادة كبيرة، ويؤدّي - منطقياً - إلى أنّ الطفل - من وجهة النظر النفسية - لن يكون له أب ولا أم.
الثاني: أن توفّر للمتزوجات الشابات مساعدة مالية لكي يتفرّغن لرعاية أطفالهن.
والطريق الثاني وحده لا يكفي، إذ يجب أن يقترن بقرار قانوني
يقضي باستخدام الأم في عملها مجدّداً بعد أن يبلغ طفلها سنّاً معيّنة، لكنّ هذه الطريقة تتميز بأنّها تمكّن الأم من تربية طفلها بنفسها دون أن تخضع للاحتياج المهين إلى الرجل.
وعلى فرض تشريع مثل هذا القانون، يجب كذلك أن نتوقّع تأثيراته على أخلاق العائلة. ومن الممكن أن يقرّر القانون عدم إعطاء مساعدة للام ذات الطفل غير الشرعي، أو يقرّر أنّ المساعدة ستسلّم إلى الأب في حالة وجود أدلّة على زنا الأم، وفي هذه الحالة سيكون من واجب الشرطة المحلّية أن تراقب سلوك المتزوجات، لكن نتائج هذا القانون لن تكون فعّالة، بينما قد تنطوي على خطر عدم رضا موجدي هذا التكامل الأخلاقي، وفي النتيجة، يمكن أن نحتمّل توقّف تدخّل الشرطة في ذلك، وعندها ستتمتع حتى الأُمّهات غير الشرعيات بالمساعدة المالية وينتهي كليّاً الدور الاقتصادي للأب في طبقة العمّال، وتصبح منزلة الأب عند الأولاد كمنزلة الكلاب والقطط.... إنّ المدنية أو على الأقل المدنية الآخذة بالتوسّع الآن تميل إلى إضعاف مشاعر الأمومة.
ومن أجل المحافظة المدنية الأكمل يحتمل أن تعطى النساء من أجل الحمل مقداراً من النقود لإقناعهن بقبوله. وفي هذه الحالة لا يلزم حتماً أنّ جميع النساء أو أكثرهن يخترن عمل الأمومة، فهو عمل كباقي الأعمال ستستقبله النساء بجدّية واهتمام. وعلى كل حال، فجميع ما ذُكر فرضيات لا أكثر والهدف من القول إنّ نهضة النساء ستؤدّي إلى
زوال سلطة الأب التي كانت منذ ما قبل التاريخ تمثّل انتصار الرجل على المرأة، وحلول الدولة محل الأب في الدولة الغربية والذي نواجهه الآن يعد تقدّماً).
إنّ إلغاء نفقة المرأة، أو كما يسمّيه هؤلاء السادة الاستقلال المادي للنساء - طبقاً للأقوال السابقة - ستكون له النتائج والآثار التالية:
إنّ زوال سلطة الأب من الأسرة، أو على الأقل، زوال أهميته والعودة إلى مرحلة سلطة الأم، وحلول الدولة محل الأب وتسلّم الأمهات المساعدة والنفقة من الدولة من الأب، يستضعف مشاعر الأمومة ويخرجها من صورتها العاطفية إلى صورة الشغل والكسب.
وبديهي أنّ نتيجة كل ذلك هو الانهيار الكامل للأسرة الذي يؤدّي قطعاً إلى انهيار الإنسانية. كل شيء يمكن أن يصحّح مستقبلاً، لكنّنا سنفقد شيئاً مهمّاً هو السعادة والسرور والتمتّع باللذات المعنوية الخاصة بالمؤسسة العائلية.
وعلى كل حال، فإنّ أنصار الاستقلال والتحرير الكامل للمرأة وطرد الأب من محيط الأسرة، يرون أيضاً أنّ الواجب الطبيعي للمرأة في إنجاب الأطفال يستلزم حقّاً ومساعدة وأحياناً أجرة يجب - في نظرهم - أن تدفعها الدولة بخلاف الرجل الذي يوجب عمله الطبيعي حقّاً.
وفي قوانين العمل العالمية يمنح العامل في أقل الحالات أُجرة
يحسب فيها حساب الزوجة والأطفال، أي إنّ قوانين العمل العالمية تعترف بحق النفقة للمرأة والأولاد.
هل أهانت لائحّة حقوق الإنسان المرأة؟
جاء في المادة 23 البند 3 من لائحة حقوق الإنسان:
(كل شخص عامل له الحق في الحصول على أجر منصف ومرضٍ يؤمّن له ولعائلته عيشاً إنسانياً).
وفي المادة 25، بندٌ ينصّ على أنّ: (كل شخص له الحق في تأمين معيشته وسلامة ورفاه نفسه وأسرته من حيث الطعام والمسكن والخدمات الطبيّة والاجتماعية اللازمة).
في هاتين المادتين ضمناً أنّ كل رجل يشكّل أسرة يجب أن يتحمّل نفقات زوجته وأطفاله، وأنّ نفقات هؤلاء تعد من نفقاته الضرورية واللازمة.
ولائحة حقوق الإنسان مع أنّها تصرّح بأنّ للمرأة والرجل حقوقاً متساوية، إلاّ أنّها لم تعتبر إعطاء الرجل النفقة للمرأة منافياً لتساوي حقوق المرأة والرجل. على هذا فالأشخاص الذين يعترفون بلائحة حقوق الإنسان ويستندون بذلك إلى مصادقة المجلسين عليها، يجب أن يتلقّوا مسألة النفقة على أنّها مسألة نهائية. فهل سيجيز عباد الغرب - الذين يطلقون اسم الرجعية والتأخّر على كل ما له لون إسلامي - لأنفسهم أيضاً أن يستهينوا بقدسية لائحة حقوق الإنسان ويعتبروها من
آثار مالكية الرجل ومملوكية المرأة؟ وأكثر من ذلك فإنّ لائحة حقوق الإنسان تذكر في المادة الخامسة والعشرين أنّ: (لكل شخص الحق - في حال البطالة أو المرض أو نقص الأعضاء أو الترمّل، أو الشيخوخة، أو جميع الحالات التي يستحيل فيها تهيئة وسائل العيش - أن يتمتّع بشروط الحياة الكريمة).
فهذه اللائحة - إضافة إلى اعتبارها فقدان الزوج فقداناً لوسيلة العيش - قد ذكرت الترمل إلى جانب البطالة والمرض ونقص الأعضاء. أي إنّها ذكرت النساء (الأرامل) في صف العاطلين والمرضى والشيوخ وناقصي الأعضاء أفليس في هذا إهانة كبرى للمرأة؟ لا شك أنّ مثل هذا التعبير لو ورد في الكتب أو الكراسات القانونية للبلدان الشرقية لتعالت صيحات الاعتراض ووصلت إلى عنان السماء، كما حدث بالنسبة لما ورد في بعض القوانين الإيرانية.
لكن الإنسان الذي ينظر بعين الواقع ولا يتأثّر بالضجيج والزعيق، ويدقّق النظر في جميع جوانب المسألة يعلم أن لا قانون الخلقة الذي جعل الرجل وسيلة من وسائل معيشة المرأة، ولا لائحة حقوق الإنسان التي اعتبرت (الترمّل) فقداناً لوسيلة العيش، ولا القانون الإسلامي الذي اعتبر المرأة واجبة النفقة على الرجل؛ قد أهان المرأة لأنّ هذا أحد جوانب القضية وهو أنّ المرأة خلقت محتاجة إلى الرجل ويعتبر الرجل ركيزة للمرأة.
إنّ قانون الخلقة - من أجل أن يربط المرأة والرجل أكثر ببعضهما،
ومن أجل أن يحكم بناء المؤسسة الأسرية التي هي الدعامة الأساسية لسعادة الإنسانية - خلق المرأة والرجل محتاجين لبعضهما، فإذا كان قد جعل الرجل المرتكز المالي للمرأة فقد جعل المرأة المرتكز الروحي والرفاهي للرجل. هذا الاحتياج المتباين قرب بينهما أكثر وزاد في اتحادها.
الفصل التاسع
مسألة الإرث
كان العالم إمّا القديم ألاّ يورث المرأة أو يعاملها في الإرث كالصغير. أي لم يكن ليمنحها استقلالاً ماليّاً أو شخصية حقوقية. وفي بعض القوانين القديمة للعالم كانوا ورثوا الفتاة، لم يورثوا أولادها، بخلاف الفتى الذي يمكن له أن يرث كما يمكن لأولاده أن يرثوا من مال جدّهم، وفي بعض القوانين الأخرى في العالم آنذاك حين كانوا يورثون المرأة كما يورثون الرجل، لم يكن إرثها حصة مفروضة وبتعبير القرآن (نصيباً مفروضاً) وإنّما كان على شكل حق للمورث في أن يوصي لابنته بنصيب إذا شاء ذلك. أنّ لأرث المرأة تاريخاً طويلاً فقد وضع المحققون والعارفون بحوثاً كثيرة كتابات مستفيضة في هذا الباب لا أرى لزوماً لنقلها حيث لخصّناها بما مرّ آنفاً.
أسباب حرمان المرأة من الإرث
كان السبب الأساس لحرمان المرأة من الإرث هو منع انتقال الثروة من عائلة إلى أخرى. فطبقاً للعقائد القديمة، يعتبر دور الأم في إيجاد الطفل دوراً ضعيفاً، وإنّ الأمهات أوعية لا غير تنمو في داخلها نطف الرجال ليوجد الولد، ومن هذا المنطلق يعتقدون أنّ أحفاد الرجل (أولاد أولاده) أولاد له وجزء من أُسرته، وأمّا أسباطه (أولاد بناته) فليسوا من
ذرّيته ولا جزءاً من أسرته، بل هم جزء من عائلة أبيهم؛ وعلى هذا الفتاة إذا ورثت ثم انتقل هذا الإرث منها إلى أولادها كان هذا انتقالاً لثروة عائلة إلى عائلة أخرى غريبة.
جاء في كتاب (إرث در حقوق مدني إيران) أي (الإرث في الحقوق المدنية الإيرانية) تأليف المرحوم الدكتور موسى العميد صفحة 8: (في المراحل القديمة، كان الدين يشكل أساس العائلة لا صلة الرحم الطبيعية)، ثم يقول: (كانت الرئاسة الدينية في الأسرة (سلطة الأب) بيد جد الأسرة، وبعد وفاته ينتقل إجراء المراسم والتشريفات الدينية للعائلة فقط بوساطة الأولاد الذكور من جيل إلى جيل، والقدماء يعتبرون الرجال وسيلة لإبقاء النسل فقط. ولما كان أبو العائلة واهب الحياة لابنه، العقائد والرسوم الدينية هي للأب. وحق حفظ النار وقراءة الأدعية الدينية المخصوصة تنتقل منه إليه، وجاء في كتب القوانين الهندية والقوانين اليونانية والرومانية أنّ قوّة الإنتاج مقصورة على الرجال، ونتيجة لهذه العقيدة القديمة فقد أصبحت الأديان مقصورة على الرجال. أمّا النساء - بدون وساطة الأب أو الزوج - فلم يكن لهنّ أي دخل في أمور الدين... ولأنّهن لم يكنّ يسهمن في المراسم الدينية؛ فقد كنّ محرومات من سائر المزايا العائلية. وعندما شرّع قانون الإرث بعد ذلك حرمت النساء منه أيضاً). لكن لحرمان المرأة من الإرث أسباباً أُخرى، من جملتها ضعف القدرة القتالية للمرأة. فحيث كان التقييم على أساس البطولات، وكان المقاتل يعد بمئة ألف من غير المقاتلين، حرمت
المرأة من الإرث بسبب عجزها عن القيام بالعمليات الدفاعية والقتالية.
وقد كان عرب الجاهلية يرفضون توريث المرأة على هذا الأساس، ولو وجد رجل في الإرث ولو في الدرجات التالية للمرأة، لم تحصل المرأة على الإرث، فعند نزول آية الإرث وتصريحها أنّ:( لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمّا قَلّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ) عجب العرب لذلك. واتفق في ذلك الوقت أن حسّان بن ثابت شاعر العرب المعروف توفي عن زوجة وعدد من البنات. فقام أولاد عمّه بالاستيلاء على جميع أملاكه ولم يتركوا شيئاً لزوجته وبناته، فشكتهم زوجته إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، فأحضرهم رسول الله (صلّى الله عليه وآله). فقالوا: إنّ المرأة تحمل السلاح ولا تقاتل العدو، إنّما نحن الذين نمسك السيف وندافع عن أنفسنا وعن هذه المرأة؛ لذا فالمال يجب أن يكون للرجال. لكنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أبلغهم حكم الله تعالى.
إرث الابن المتبنّى
كان أعراب الجاهلية يتبنّون ولداً ويورثونه كما يرث الابن الحقيقي. وعادة تبنّي الأبناء كانت موجودة لدى شعوب أخرى منها إيران والرومان القدماء. وطبقاً لهذه العادة، كان الابن المتبنّى كونه ذكراً، يتمتّع بمزايا لم تكن تتمتّع بها البنات الصلبيات. فمن جملة ميزات الابن المتبنّى أن يرث، وكذلك يمنع زواج الشخص من زوجة ابنه المتبنّى
بعده. وقد ألغى القرآن الكريم هذه العادة.
إرث ضامن العهد (ضامن الجريرة)
كانت للعرب عادة أخرى في الإرث ألغاها القرآن الكريم أيضاً هي توريث ضامن العهد، إذ كان الرجلان الغريبان عن بعضهما يعقدان بينهما حلفاً يقول أحدهما: (دمك دمي، وثأرك ثأري، وحربك حربي، وسلمك سلمي، وترثني وأرثك) فيقول آخر (قبلت). وبموجب هذا الحلف، يقوم هذان الرجلان الغريبان في أثناء مدّة حياتهما بالدفاع عن بعضهما فإذا مات أحدهما ورثه الآخر.
المرأة جزء من الإرث
كان العرب - أحياناً - يعتبرون زوجة الميت جزءاً من أمواله وممتلكاته ويتعاملون معها على أنّها جزء من الإرث. فإذا كان للميت ابن من امرأة أخرى فإنّه يستطيع بإلقاء ثوبه على زوجة أبيه أن يعتبرها ملكاً له. ثم يقوم حسب رغبته إمّا بالزواج منها أو بتزويجها من شخص آخر وأخذ مهرها. هذه العادة لم تكن مقتصرة على العرب وقد نسخها القرآن.
وفي القوانين القديمة للهند واليابان والرومان واليونان وإيران أمور كثيرة غير جائزة في مسألة الإرث، ولو أردنا نقل ما ذكره المطلعون من تلك لاستغرق عدّة مقالات.
إرث المرأة في إيران ساسان
كتب المرحوم سعيد نفيسي في كتابه (تاريخ اجتماعي إيران أز زمان ساسانيان تا انقراض امويان) أي (التاريخ الاجتماعي لإيران منذ عهد الساسانيين إلى انقراض الأمويين) في الصفحة 42 ما يلي: (كانت في باب تشكيل الأسرة مسألة طريفة أخرى في الحضارة الساسانية، ذلك أنّ الابن حين يبلغ سن الرشد يقوم الأب بتزويجه من إحدى نسائه هو. وهناك مسألة أخرى هي أنّ المرأة في الحضارة الساسانية لم تكن لها شخصية حقوقية، وكانت للأب والزوج صلاحيات واسعة جداً في التصرّف بأموالها. وحين كانت البنت تبلغ الخامسة عشرة من عمرها ويكتمل رشدها، كان من واجب الأب أو رئيس الأسرة أن يزوجها، أمّا سن زواج الفتى فكانت عشرين عاماً، وكانت موافقة الأب شرطاً في الزواج، وكانت الفتاة التي تتزوج لا ترث أباها أو كافلها الأول، كما لم يكن لها الحق في اختيار الزوج، أمّا إذا قصّر الأب في تزويجها عند البلوغ، فيكون من حقّها أن تبادر إلى الزواج غير المشروع، وفي هذه الحالة لا ترث أباها. لم يكن عدد النساء اللائي يسمح للرجل بالزواج منهن محدوداً، وقد وجد في الوثائق اليونانية أنّ رجلاً كان يحتفظ في بيته بمئات من النساء، أصول الزواج في العهد الساساني - كما ورد في الكتب الدينية الزرداشتية - معقّدة جداً ومتشابكة لكن الرائج منها كان خمسة أنواع:
1 - المرأة التي تتزوج برضا الأب والأم وتلد أولاداً يعتبرون أولادها في الدنيا والآخرة وتسمّى (پادشاه زن)(1) .
2 - المرأة التي تكون وحيدة أبويها ويسمّونها (اوك زن)(2) تهب طفلها الأول لأبويها ليكون عوضاً عن ابنتهم التي تركت البيت وتزوّجت، وتسمّى عندها (بادشاه زن) أيضاً.
3 - إذا بلغ الولد سن الرشد فمات أعزب، قام أهله بتجهيز امرأة غريبة تزويجها من رجل غريب نيابة عن ولدهم، وتسمّى هذه المرأة (المرأة المدعاة) وما تلد من أولاد فنصفهم للزوج المتوفّى يكونون أولاده في الآخرة والنصف الثاني للزوج الحي.
4 - الأرملة التي تتزوّج للمرة الثانية وتدعى (چغر زن)(3) وإذا لم تنجب من زوجها الأول سمّيت (سذر زن)(4) .
5 - المرأة التي تتزوّج بدون رضا والديها تُعد أحط نوع من النساء وتدعى (خود سراى زن)(5) ولا ترث أبويها، إلاّ إذا بلغ ابنها سن الرشد
____________________
(1) أي: (الملكة).
(2) أي المرأة الفريدة التي لا نظير لها، أو المرأة الوحيدة.
(3) أي الخادمة.
(4) أي زوجة الشخص اسمياً فقط.
(5) أي التي لا تستشير أحداً في أمورها.
وعقد لها مجدّداً بصفة (أوك زن)(1) .
سهم المرأة من الإرث من وجهة نظر الإسلام
في قوانين الإسلام لا يوجد في باب الإرث أي من هذه التعقيدات التي ذكرت، أمّا الشيء الذي ينتقده المنادون بحق المساواة، في القانون الإسلامي هو كون سهم المرأة معادلاً لنصف سهم الرجل من الإرث. فمن وجهة نظر الإسلام، يرث الولد ضعف ما ترثه البنت، ويرث الأخ ضعف ما ترثه الأخت، ويرث الزوج ضعف ما ترثه الزوجة، إلاّ مع الأبوين فإنّه حين يتوفّى رجل وله أولاد ويكون والده على قيد الحياة، فإنّ كلاًّ منهما يرث سدس ما تركه الميت.
وسبب تحديد الإسلام لسهم المرأة في الإرث بنصف سهم الرجل هو الوضع الخاص للمرأة من حيث المهر والنفقة والجندية وبعض القوانين الجزائية، أي إنّ الوضع الخاص بالمرأة من حيث الإرث إنّما هو نتيجة للوضع الخاص الذي تتمتّع به المرأة في المهر والنفقة والأمور الأخرى.
إنّ الإسلام - بموجب الأسباب التي ذكرناها في المقالات السابقة - يرى المهر والنفقة أموراً مهمّة ومؤثّرة في إحكام عرى الزواج وتأمين
____________________
(1) سبق تعريف مثل هذه المرأة والشروط المترتبة عليها في البند الثاني من هذا الموضوع. المصحّح.
رفاه الأسرة وإيجاد الوحدة بين الزوجين، إنّ إلغاء المهر والنفقة وعلى الأخص النفقة - من وجهة نظر الإسلام - يؤدّي إلى تزلزل أساس الأسرة وجر المرأة إلى الفحشاء. ولأنّ الإسلام يرى المهر والنفقة شرطاً في العقد؛ فقد رفعهما عن كاهل المرأة وفرضهما على ميزانية الرجل، فهو يريد هنا أن يجبر هذا الفرض عن طريق الإرث، فجعل سهم الرجل ضعف سهم المرأة؛ إذاً فالمهر والنفقة هما اللذان أديا إلى تقليل سهم المرأة في الإرث.
اعتراض عُبّاد الغرب
بعض عبّاد الغرب حين يتحدثون عن العدالة ويتخذون من موضوع نقص سهم المرأة في الإرث وسيلة للتنديد بالإسلام، يطرحون مسألة المهر والنفقة فيقولون ما الذي يدعونا إلى أن نجعل سهم المرأة في الإرث أقل من سهم الرجل ثم نجبر النقص بالمهر والنفقة؟ لماذا نلف وندور في الأعمال ونريد أن نضع اللقمة في الفم من خلف العنق؛ فلنساو بين سهم المرأة والرجل في الميراث، ثم لا نضطر إلى جبران هذا النقص بالمهر والنفقة.
أوّلاً: إنّ هذا من قبيل القول بأنّ المربيات أشفق من الأم. لقد وضعوا العلّة بدل المعلول والمعلول مكان العلّة. إنّهم تصوّروا أنّ المهر والنفقة هما نتيجة لوضع المرأة الخاص في الإرث، وغفلوا عن أنّ الوضع الخاص للمرأة في الإرث هو نتيجة المهر والنفقة.
ثانياً: إنهم ظنّوا أنّ المسألة هنا هي مسألة مالية واقتصادية صرفة. بديهي أنّه لو كانت المسألة ذات جانب اقتصادي محض لما كان هناك سبب لوضع المهر والنفقة ولا لتقليل سهم المرأة في الإرث. فكما قلنا في المقالات السابقة إنّ الإسلام قد أخذ في نظر الاعتبار جوانب متعدّدة لهذه المسألة منها طبيعة ومنها نفسية، فمن ناحية نظر إلى احتياجات المرأة الكثيرة فيما يخص إنجاب الأطفال، في الوقت الذي يكون الرجل فيه متحرّرا من ذلك. ومن ناحية ثانية قدرتها التي تقل عن قدرة الرجل في الإنتاج واكتساب المال. ومن ناحية ثالثة فإنّ إنفاق المرأة للمال أكثر من إنفاق الرجل له، بالإضافة إلى الملاحظات النفسية والروحية المتعلّقة بكل من المرأة والرجل. وبتعبير آخر: ما يرتبط بعلم نفس المرأة والرجل، يجب أن يمثّل دور المنفق بالنسبة لإحكام العلاقة العائلية، فالإسلام قد أخذ كل هذه الأمور بنظر الاعتبار وقرّر ضرورة وجود المهر والنفقة. هذه الأمور الضرورية واللازمة أدّت بشكل غير مباشر إلى الضغط على ميزانية الرجل، ولهذا أمر الإسلام - من أجل جبران ما فرض على ميزانية الرجل - أن يكون سهم الرجل من الإرث ضعف سهم المرأة.
إذاً فالمسألة ليست مسألة اقتصادية ومالية بحتة، كي يقال ما الداعي لتقليل سهم المرأة في جانب ومن ثمّ تعوضيها في جانب آخر.
اعتراض زنادقة صدر الإسلام على مسألة الإرث
قلنا إنّه من وجهة نظر الإسلام، يعتبر المهر والنفقة علّة والوضع الإرثي للمرأة معلولاً، وهذا المطلب لم يثر مؤخّراً فحسب، بل قد أثير منذ صدر الإسلام.
فابن أبي العوجاء رجل عاش في القرن الثاني بعد الهجرة ولم يكن يؤمن بربٍّ ولا دين، هذا الرجل كان يستغل حرية ذلك العصر ويطرح آراءه الإلحادية في كل مكان، حتى أنّه كان يأتي أحياناً إلى المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلّى الله عليه وآله) ليناقش علماء ذلك العصر في التوحيد والمعاد وأصول الإسلام، وقد كان أحد اعتراضاته على الإسلام ما يلي: (ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً ويأخذ الرجل سهمين؟)
فأجابه الإمام الصادق (عليه السلام): (إنّ ذلك كان سبب أنّ الإسلام قد أعفى المرأة من الجهاد في سبيل الله وفرض لها على الرجل المهر والنفقة، كما أنّه في بعض الجنايات غير العمدية، حين يجب على أقارب الجاني أن يدفعوا الديّة، تعفى المرأة من الاشتراك في الدفع؛ لهذا جعل سهم المرأة في الإرث أقل من سهم الرجل) فالإمام الصادق (عليه السلام) قد علّل صريحاً وضع المرأة الخاص في مسألة الإرث بالمهر والنفقة وسقوط الجهاد والديّة. وقد سُئل أئمّة الدين مثل هذه الأسئلة وأجابوا جميعاً بنفس هذه الإجابة.
الفصل العاشر
حق الطلاق
(1) حق الطلاق
لم يهتم عصر من العصور بخطر انهيار مؤسسة الأسرة والعواقب الناتجة عن ذلك كما اهتمّ بها عصرنا، ولم يبتل عصر من الناحية العملية كما ابتلي هذا العصر بهذا الخطر وبالآثار السيئة المترتّبة عليه.
ويسعى المقنّنون والحقوقيون وعلماء النفس كل من خلال الوسائل المتيسّرة لديه من أجل إحكام بناء المؤسسة الزوجية وتقويتها وتحصينها، ولكن (من حكم القضاء، أنّ السكنجبين زاد في الصفراء)(1) فالإحصاءات تدل على ازدياد نسبة الطلاق سنة بعد أخرى، كما يخيّم خطر الانفصال على كثير من العوائل.
ومن المعروف أنّه حين يتوجّه إلى مكافحة أحد الأمراض والوقاية منه بالمساعي المادية والمعنوية، يخف أثره وقد يمحى نهائياً، أمّا مرض الطلاق فعلى العكس من ذلك.
____________________
(1) مثل إيراني والسكنجبين شراب يصنع من مغلي الخل والسكر ويفترض أنّه يطرد الصفراء.
ازدياد الطلاق في العالم الحديث
في الماضي كان التفكير في الطلاق وعواقبه السيئة وأسباب وجوده وزيادة وقوعه وطرق الوقاية منه، أقل ممّا نحن عليه الآن، إلاّ أنّ حالات الطلاق آنذاك كانت أقل، وانهيار الأعشاش كان في دائرة أضيق ممّا هو عليه الآن.
من المسلّم به أنّ الفرق بين الأمس واليوم هو أنّ أسباب الطلاق قد ازدادت اليوم، وقد اتخذت الحياة الاجتماعية شكلاً يزيد في مسببات الانفصال والفرقة وتصدّع العلاقات العائلية؛ وهذا ما جعل مساعي العلماء وأهل الخير عقيمة. وممّا يؤسف له أنّ مستقبلاً أخطر ينتظرنا من هذه الناحية.
في العدد 105 من مجلة (زن روز) نقلت مقالة شيّقة عن مجلة نيوز ويك تحت عنوان (الطلاق في أمريكا) ذكرت أنّ: (الحصول على الطلاق في أمريكا سهل سهولة الحصول على التاكسي).
وتقول المجلة أيضاً: (ينتشر بين شعوب أمريكا مثلان حول الطلاق، أحدهما، يقول: (حتى أسوأ أنواع الصلح بين المرأة وزوجها أفضل من الطلاق) والذي أطلق هذا المثل هو شخص اسمه (سرفانتس) قبل حوالي ربع قرن. أمّا المثل الثاني فقد قاله رجل اسمه (سامى كوهين) في النصف الثاني من القرن العشرين، وذلك في مقابل المثل الأول ومضاداً له وهو: (الحب الثاني أهنأ للقلب).
ويظهر من المقالة المذكورة أنّ المثل الثاني قد فعل فعله في أمريكا، إذ استمرّت تقول: (إنّ سراب الطلاق لا يجتذب (حديثي العهد بالزواج) فحسب، بل يجتذب كذلك أُمّهاتهم، يجتذب الزوجات والأزواج القدامى، بحيث إنّ نسبة الطلاق في أمريكا منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن لم تهبط عن 000/400 حالة سنوياً 40% منها زيجات مضى عليها عشر سنوات أو أكثر، و13% منها كان الزواج قد دام فيها أكثر من عشرين عاماً. والسن المتوسّط لمليوني مطلقة أميركية هو 45 سنة، و62% من المطلقات كنّ وقت الطلاق أُمّهات لأطفال دون الثامنة عشرة من العمر. إنّ النساء المذكورات يشكّلن في الواقع جيلاً خاصاً).
وتستمر المجلة قائلة: (بالرغم من أنّ المرأة الأمريكية - من شابات أو متوسّطات في العمر - لسن سعيدات وتستشف كآبتهن من كثرة النساء اللائي يراجعن عيادات الأطباء المتخصصين بالأمراض النفسية والعصبية، أو اللجوء إلى الكحول، أو ازدياد نسبة الانتحار بينهن. فمن بين كل أربع مطلقات تلجأ واحدة إلى تعاطي الكحول، كما أنّ نسبة الانتحار بينهن تعادل ثلاثة أضعافها عند المتزوّجات. وباختصار: إنّ المرأة الأمريكية ما إن تخرج من المحكمة ظافرة بالطلاق، حتى تدرك أنّ الحياة بعد الطلاق ليست جنّة كما كانت تتصوّرها... فالعالم الذي يعتبر الزواج أقوى الروابط الإنسانية بعد القوانين الطبيعية من الصعب جداً أن ينظر باحترام إلى امرأة قضت على هذه الرابطة. [ من الممكن أن يكر المجتمع هذه المرأة ويعبدها وحتى أنّه
قد يغبطها ]* ، إلا أنّ - من المؤكّد - أنّ أي شخص لا ينظر إليها نظر مَن يرغب في إشراكها في حياته الخاصة، والتي يسعى من خلالها إلى السعادة).
وتطرح هذه المقالة هذا السؤال: (هل إنّ سبب ازدياد الطلاق هو عدم الانسجام الأخلاقي بين الزوجة والزوج أم شيء آخر؟) وتقول: (إذا اعتبرنا عدم الانسجام هو سبب الانفصال بين (الأزواج الجدد) فبماذا نعلّل انفصال (الأزواج القدامى)؟
فمع الأخذ بنظر الاعتبار المكاسب التي تعطيها القوانين الأمريكية للمطلّقة يكون جواب السؤال هو: إنّ سبب الطلاق في الزيجات ذات العشر أو العشرين سنة ليس عدم الانسجام بين الزوجين، وإنّما عدم الرغبة في تحمّل الخلافات القديمة، والرغبة في الحصول على ملذّات أكثر ومتع جديدة. ففي عصر أقراص منع الحمل وعهد الثورة الجنسية وعلو مكانة المرأة، شاع بين كثير من النساء رأي مفاده أنّ المتعة واللذة مقدّمة على المحافظة على المؤسسة العائلية، فترى زوجين عاشا معاً لسنين وأنجبا أطفالاً، واشتركا في الحزن والسرور، ثم تجد المرأة فجأة تسعى للحصول على الطلاق بدون أن يكون قد طرأ على وضع زوجها المادي أو المعنوي طارئ، السبب في ذلك يعود إلى أنّها كانت حتى الليلة البارحة مستعدة لأن تتحمّل الحياة الرتيبة، أمّا الآن فلم تعد مستعدّة لذلك... إنّ المرأة الأمريكية اليوم أكثر طلباً للّذة من امرأة الأمس وأقلّ تحمّلاً للعوز من جدّتها).
____________________
* هذه العبارة مبهمة بالنسبة إلينا على الأقل. [ الشبكة ].
الطلاق في إيران
إن ازدياد الطلاق ليس وقفاً على أمريكا، إنّه مرض هذا القرن. إنّ كل مكان دخلته الآداب والعادات الغربية الجديدة أكثر؛ زادت فيه نسبة الطلاق أيضاً. فلو نظرنا إلى وطننا إيران - على سبيل المثال - لوجدنا أن الطلاق في المدن أكثر منه خارجها والأكثر منه بكثير في طهران التي راجت فيها الآداب والعادات الغربية، أكثر من المدن الأخرى.
فقد نشرت جريدة اطلاعات في عددها 11512 إحصائية مختصرة للزواج والطلاق في إيران جاء فيها: (إنّ أكثر من ربع وقائع الطلاق المسجّلة في كل البلاد تقع في طهران وحدها، أي أنّ 27% من حوادث الطلاق المسجّلة تخص طهران، بالرغم من أنّ نسبة سكّان طهران إلى مجموع سكان البلاد هو 10% وبصورة عامّة فإنّ النسبة المئوية للطلاق في مدينة طهران أكثر من النسبة المئوية للزواج فيها. وتشكّل وقائع الزواج في طهران 15% من مجموع زيجات البلاد).
محيط أمريكا المشجّع على الطلاق
والآن مادام الحديث قد جرّنا إلى مسألة ازدياد نسبة الطلاق في أمريكا، وما ذكرته مجلة نيوزويك من أنّ المرأة الأمريكية تقدّم المتعة واللذة على الحفاظ على مؤسسة الأسرة، فلنخط خطوة أخرى إلى الإمام لنرى لماذا أصبحت المرأة الأمريكية كذلك؟
ممّا لا شك فيه أنّ ذلك لا علاقة له بطبيعة المرأة الأمريكية، بل له
سبب اجتماعي، إنّ محيط أمريكا هو الذي منح المرأة هناك هذا الاستعداد. إنّ عابدي الغرب عندنا يسعون في جعل النساء الإيرانيات يسلكن نفس الطريق الذي سلكته نساء أمريكا. ولو تحقّق هذا الأمل الذي ظلّ يراودهم طويلاً؛ لكان مصير المرأة الإيرانية والبيت الإيراني هو نفس مصير المرأة الأمريكية والبيت الأمريكي.
كتبت النشرة الأسبوعية (بامشاد) في عددها 66 (4/5/44)(1) تقول: (انظروا إلى أيّ مدى وصل الأمر حتى أنّ الفرنسيين تعالت صيحاتهم بأنّ الأمريكان يطلعون علينا بفتنة جديدة). وكان العنوان الكبير لمقال جريدة (فرانس سوار) هو (النساء العاريات الصدور، يقدّمن الخدمات في أكثر من مئتي مطعم وملهى في كاليفورنيا).
في هذه المقالة جاء أن (المونوكيني) - وهو مايوه يترك صدر المرأة عارياً قد اعتبر لباس عمل في سان فرانسيسكو ولوس أنجلس، والعشرات من دور السينما في نيويورك تعرض أفلاماً خاصة بالمسائل الجنسية، وقد ألصقت على واجهة هذه الدور صور النساء العاريات، وبعض هذه الأفلام كانت تحمل الأسماء التالية: (تبادل الزوجات)، (فتيات ضد الأخلاق)، (البنطلون الذي لا يستر شيئاً). وفي واجهات المكتبات قلّما ترى كتاباً لا يعرض غلافه صورة امرأة عارية، حتى الكتب التقليدية، وتجد بين الكتب كتباً متوفّرة أكثر من غيرها تحمل
____________________
(1) التقويم الهجري الشمسي المصادق لعام 1965م.
عناوين مثل: (الحالة الجنسية للأزواج الأمريكان) و(الحالة الجنسية لرجال الغرب)، و(الحالة الجنسية للشبّان دون العشرين عاماً)، و(الأساليب الجديدة في ممارسة الجنس طبقاً لأحدث المعلومات).
(وعندها يسأل محرّر جريدة فرانس سوار نفسه بتعجّب وقلق قائلاً إلى أين تسير أمريكا؟).
وهنا تقول (بامشاد): (الحقيقة أنّها (لتذهب هي إلى حيث شاءت)... ولكن أتألّم من أجل بعض الناس في بلدي الذين يتصوّرون أنّهم قد عثروا على النموذج المناسب في الساحة العالمية، وإذا بهم لا يميّزون أيديهم من أرجلهم في هذا السبيل).
إذاً فقد أصبح واضحاً أنّ المرأة الأمريكية إذا كانت طائشة وفضّلت طلب المتعة على الوفاء للزوج والعائلة فليس كل الخطأ خطأها، إنّما هو المحيط الاجتماعي الذي أمسك بالمعول ليهدم المؤسسة العائلية المقدّسة من أساسها.
عجباً لطلائع هذا العصر! إنّهم يزيدون يوماً بعد يوم في العوامل الاجتماعية المسبّبة للطلاق وانهيار المؤسسة العائلية، ويتسابقون فيما بينهم من أجل ذلك، ثم يصرخون لماذا زادت نسبة الطلاق إلى هذا الحد؟ إنّهم من ناحية يشجّعون أسباب الطلاق ويريدون من ناحية أخرى أن يحولوا دونه بقوّة القانون: وهنا ينطبق بحقّهم بيت الشعر الفارسي القائل:
اين حكم چنين بود |
كه كج دار ومريز |
أي: كونوا مراوغين، تظاهروا بالشيء ولا تعملوا به
فرضيات
والآن لنتناول البحث من أساسه، ولننظر هل الطلاق - من الناحية النظرية - أمر جيد أم سيء؟ وهل من الأفضل أن تنهار المؤسسات العائلية الواحدة تلو الأخرى؟ وإذا كان هذا جيداً، فكل ما يؤدّي إلى زيادة نسبة الطلاق جيد أيضاً، أم أنّ باب الطلاق يجب أن يغلق بالمرّة ويصبح رباط الزوجية أبدياً بصورة إجبارية ويحال دون كل ما يؤدّي إلى إضعاف رباط الزواج المقدّس؟ أم أنّ هناك خياراً ثالثاً هو أن القانون لا يغلق باب الطلاق بالمرّة بوجه المرأة والرجل، بل يتركه مفتوحاً، ويحدّد ضرورته في بعض الحالات، وفي نفس الوقت الذي لا يغلق فيه القانون باب الطلاق تماماً، يسعى المجتمع جدّياً من أجل القضاء على موجبات الفرقة والانفصال في حياة الزوجين.
يجب على المجتمع أن يكافح أسباب الفرقة والانفصال بين الزوجين وتشريد الأطفال، أمّا إذا هيّأ المجتمع موجبات الطلاق فلا فرق في أن يغلق القانون هذا الباب أو يفتحه.
فإذا تقرّر أن يترك القانون باب الطلاق مفتوحاً، فبأيّ صورة يجب أن يكون ذلك؟ هل يبقى الباب مفتوحاً للرجل فقط أم للمرأة فقط أم
لكليهما معاً؟
وبناءً على الاحتمال الثالث، هل يكون الباب المفتوح للمرأة والرجل على نحو واحد؟ فيجعل طريق الخروج من حصار الزواج واحداً لكليهما؟ أم الأفضل أن يكون لكل منهما باب مستقل؟
وعلى كل حال، فهناك خمس فرضيات حول الطلاق هي:
1 - عدم الاهتمام بأمر الطلاق ورفع جميع القيود القانونية والأخلاقية التي تحول دون وقوعه.
يؤيّد هذه النظرية الأشخاص الذين ينظرون إلى الزواج بمنظار الاستمتاع فقط، والذين لا يأخذون بنظر الاعتبار قدسية وقيمة العائلة بالنسبة إلى المجتمع، ويعتقدون أنّ العلاقات الزوجية كلّما تجدّدت وتغيّرت على وجه السرعة، كانت أمتع للمرأة والرجل، والشخص الذي يقول: (الحب الثاني أهنأ للقلب دائماً) يؤيّد هذه النظرية. في هذه النظرية أغفلت القيمة الاجتماعية للمؤسسة العائلية، ونسيت المسرّة والصفاء والإخلاص والسعادة التي لا تأتي إلا من دوام العلاقة الزوجية واتحاد روحين في روح واحدة. هذه النظرية هي أحدث نظرية فجّة في هذا الباب.
2 - إنّ الزواج ميثاق مقدّس، ووحدة القلوب والأرواح؛ لذا يجب أن يحتفظ به إلى الأبد، كما يجب أن يمحى اسم الطلاق من قاموس المجتمع البشري، ويفهم الزوجان اللذان يرتبطان بهذا العهد أنّه لن يفرق بينهما غير الموت. هذه الفرضية هي التي تحظى بتأييد الكنيسة الكاثوليكية
منذ عدّة قرون ولن ترفع اليد عنها مهما كلّفها الأمر.
لكن مؤيّدي هذه النظرية في العالم في تناقص، فلا يعمل بها اليوم إلاّ في إيطاليا وأسبانيا الكاثوليكية. ونحن نقرأ على الدوام في الصحف أنّ أصوات النساء والرجال الإيطاليين ترتفع بالاعتراض على هذا القانون، وأنّ السعي مستمر لإقرار قانون الطلاق ووضع حد للزيجات الفاشلة وإنقاذها من الملل.
قرأت - قبل مدّة - مقالاً مترجماً عن صحيفة الديلي الكسبريس في إحدى الصحف المسائية تحت عنوان (الزواج في إيطاليا يساوي استعباد المرأة). جاء في هذا المقال: (إنّه في الوقت الحاضر وبسبب عدم وجود الطلاق في إيطاليا، فإنّ كثيراً من الأفراد يتجهون إلى ممارسة العلاقات الجنسية غير المشروعة) وطبقاً لذلك المقال: (ففي الوقت الحاضر يوجد ما يزيد على الخمسة ملايين إيطالي يعتقدون أنّ حياتهم ليست إلاّ خطيئة محضة وعلاقات غير مشروعة).
وقد نقلت نفس الصحيفة عن صحيفة الفيغارو أنّ منع الطلاق قد سبّب مشلكة كبيرة للشعب الايطالي؛ ذلك أن كثيراً من المواطنين تخلّوا عن الجنسية الإيطالية لهذا السبب. وقد قامت مؤخّراً إحدى المؤسسات الإيطالية باستفتاء لمعرفة وجهة نظر الايطاليات فيما إذا كان إقرار قانون الطلاق مخالفاً للمبادئ الدينية أم لا؟ وكان الجواب سلباً لدى 97% من النساء.
أمّا الكنسية فتصر على رأيها، وتحاول أن تثبّت قدسية الزواج ووجوب تقوية أُسسه.
إنّ تقديس الزواج ووجوب تقويته والحيلولة دون تصدّعه أمر مقبول، ولكن بشرط أن يبقى هذا الرباط - عملياً - مصوناً من قِبَل الزوجين؛ إذ قد يصبح الانسجام بين الزوجين في بعض الحالات أمراً مستحيلاً، وفي هذه الحالات لا يمكن الإبقاء على العلاقة بينهما بقوّة القانون ثم نسمّي ذلك تقوية للزواج، إنّ فشل نظرية الكنيسة حتمي، وليس بعيداً أن تقوم الكنيسة مكرهة بمراجعة آرائها؛ لذا لا نرى ضرورة للبحث أكثر من ذلك في رأي الكنيسة وانتقاده.
3 - أن يكون الزواج قابلاً للفسخ من قِبَل الرجل وغير قابل لذلك أصلاً من قِبَل المرأة. ولهذا الفرض أنصار في العالم القديم، أمّا في عالم اليوم فلا أظن أنّ له مؤيّدين وعلى كل حال فهذا الفرض لا يحتاج كذلك إلى بحث ونقد.
4 - إنّ الزواج باعتباره المؤسسة المقدّسة للعائلة محترم بحد ذاته، لكن يجب أن يفتح باب الطلاق أمام الزوجين في ظروف خاصة، ويجب أن يكون طريقة خروج الزوجة من هذا المأزق على نحو واحد.
أنصار هذه الفرضية هم أدعياء تشابه حقوق المرأة والرجل في الأسرة، والتي يطلقون عليها خطأً اسم حق المساواة. وفي نظر هذه
المجموعة أنّ جميع الشروط والقيود والحدود التي فُرضت على المرأة يجب فرضها على الرجل، ونفس الطرق التي فُتحت للرجل للخروج من هذا المأزق يجب أن تُفتح للمرأة، وإلاّ وقع الظلم والتمييز والحرام.
5 - إنّ الزواج مقدّس والمؤسسة العائلية محترمة والطلاق بغيض، فيجب على المجتمع أن يقضي على أسباب الطلاق. وفي نفس الوقت يجب أن لا يغلق القانون باب الطلاق بوجه الزيجات الفاشلة. وطريق الخروج من قيد الزواج يجب أن تكون مفتوحة للرجل والمرأة على أن تكون طريقة خروج الرجل من هذا المأزق معيّنة وطريقة خروج المرأة معيّنة هي الأخرى، ومن جملة المجالات التي لا تتشابه فيها حقوق المرأة والرجل هي الطلاق.
هذه النظرية هي نفسها التي جاء بها الإسلام، وتطبّقها البلدان الإسلامية بصورة ناقصة (وليست بشكل كامل).
2 - حق الطلاق
الطلاق في عصرنا مشكلة عالمية كبرى، فالكل يئنّون ويشكّون، فالذين يُمنع الطلاق في قوانينهم بصورة عامة قد وصلت صرخاتهم إلى عنان السماء بسبب تحريم الطلاق وإغلاق طريق التخلّص من الزيجات الفاشلة التي تحدث قهراً. وهناك مَن أعطوا الرجل فقط حق الطلاق، وهؤلاء أيضاً يشكون من ناحتين:
1 - من ناحية حوادث الطلاق الغادر من قِبل بعض الرجال الذين يثور في قلوبهم فجأة هوى الزواج من المرأة بعد سنين من الزواج الأول، وبزيارة واحدة إلى دائرة الأحوال الشخصية(1) يطلّق زوجته القديمة ويطردها من عشّها الذي أنفقت فيه عمرها وشبابها وطاقتها وسلامتها، ولم تكن لتصدّق أنّ أحداً يمكن أن يستولي على عشّها الدافئ هذا ويطردها منه.
2 - من ناحية الامتناع الشائن من قِبل بعض الرجال عن تطليق الزوجة التي لها أمل في حصول الانسجام بينها وبينه.
يحدث كثيراً أنّ الخلافات الزوجية - ولأسباب خاصة - تصل إلى حد لا أمل في تفاديها وإعادة الصفاء والمودّة إلى سابق عهدهما، وتفشل
____________________
(1) في الجمهورية الإسلامية توجد عدّة فروع لدائرة الأحوال الشخصية كل منها يسمّى بـ (محضر) أو (دفتر ازدواج وطلاق). المصحّح.
كل محاولات الإصلاح بينهما، ويسود النفور الشديد بين الزوجين وينفصلان عن بعضهما عملياً. ففي مثل هذه الحال يدرك كل عاقل أنّ الحل محصور في قطع هذه الرابطة قانونياً كما قطعت عملياً ليذهب كل من الزوجين باحثاً عن زوج آخر يعيش معه. لكن بعض الرجال يمتنع عن الطلاق ويترك المرأة بين بين، لا هي متزوجة ولا هي مطلّقة، كما عبّر القرآن الكريم عنها بقوله:( ... فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ) .
من أجل تعذيبها وحرمانها مدّة العمر من التمتّع بالحياة الزوجية.
بوجود مثل هؤلاء الأشخاص الذين لا يملكون من الإسلام إلاّ الاسم، ويقدمون هذه الإعمال باسم الإسلام وبالاستناد إلى القوانين الإسلامية، تولّدت الشبهة لدى الذين لا يدركون عمق روح التعاليم الإسلامية في: هل إنّ الإسلام قد قصد حقّاً أن يكون الطلاق على هذا النحو؟
إنّهم يقولون بلهجة المعترض: هل إنّ الإسلام قد أعطى فعلاً للرجال الحق بأن يمارسوا - مرة عن طريق الطلاق ومرة عن طريق منع الطلاق - أي نوع من التعذيب تهواه قلوبهم مع المرأة مع اطمئنان ضمائرهم بأنّهم إنّما يمارسون حقّهم المشروع والقانوني؟
يقولون: أو ليس هذا ظلماً؟ وإذا لم يكن هذا هو الظلم بعينه فما هو الظلم إذاً؟ أو لم تقولوا إنّ الإسلام يعارض الظلم مهما كانت صوره وأشكاله، وأنّ القوانين الإسلامية قد بُنيت على أساس الحق والعدل؟
فإذا كان هذا العمل ظلماً، والقوانين الإسلامية قد بُنيت على أساس الحق والعدالة، فأخبرونا ماذا فعل الإسلام من أجل منع وقوع مثل هذه المظالم؟
لا شك أنّ مثل هذه التصرّفات ظلم، وسنذكر فيما بعد ماذا أعدّ الإسلام لمنع حدوث هذه المظالم، لكن هناك شيء آخر لا يمكن إغفاله وهو: ما هي الطرق التي يجب اتباعها للحيلولة دون وقوع مثل هذا الظلم؟ وهل إنّ الذي تسبّب في وقوع هذه المظالم هو قانون الطلاق وحده، وبإلغاء هذا القانون فقط يمكن الحيلولة دون وقوعها؟ أم أنّ جذور هذه المظالم يجب أن يبحث عنها في مكان آخر وإلغاء القانون لا يمكن أن يحول دون وقوعها؟
إنّ الفرق بين نظرة الإسلام ونظرة بعض النظريات الأخرى في حل المشاكل الاجتماعية هو أنّ البعض يتصوّر أنّ جميع المشاكل حلّها بوضع قانون، أو بإلغاء قانون. لكنّ الإسلام يدرك أنّ القانون لا يمكن أن يكون مؤثّراً إلاّ ضمن دائرة العلاقات الجافة والوضعية بين أفراد البشر. أمّا حين توجد العلاقات العاطفية والقلبية، فلا يمكن للقانون وحده أن يعمل شيئاً، إنّما يجب استخدام تدابير أخرى للحل.
إنّنا سنثبت أنّ الإسلام - في المسائل التي يمكن أن يؤثّر فيها القانون - قد استخدم قوّة القانون ولم يقصر أبداً في هذا المجال.
الطلاق الغادر:
نبحث أولاً في مشكلتنا الأولى اليوم، أي الطلاق الغادر:
إنّ الإسلام يعارض الطلاق بشدّة، إنّه يعمل على ألاّ يقع الطلاق قدر الإمكان، لكنّه أجاز الطلاق كحل اضطراري حين ينحصر الحل بالافتراق، وهو يعتبر الرجال الذين يكثرون من الزواج والطلاق أو ما يسمّون (المطلاقين) أعداء الله تعالى.
وقد ورد في الكافي: أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) سأل رجلاً:
- ماذا فعلت بزوجتك؟ قال: طلقتها.
قال (صلّى الله عليه وآله): هل رأيت منها سوءاً؟
قال: كلاّ، لم أر منها سوءاً.
ومرت الأيام وتزوّج ذلك الرجل ثانية.
فسأله النبي (صلّى الله عليه وآله): هل تزوّجت ثانية؟
قال: بلى.
ومرّ وقت آخر ثم لقيه النبي (صلّى الله عليه وآله) فسأله: ما فعلت بزوجتك هذي؟
قال: طلّقتها.
قال (صلّى الله عليه وآله): أرأيت منها سوءاً؟
قال: كلاّ، لم أر منها سوءاً.
ومرّت الأيام وتزوّج ذلك الرجل ثالثة.
وسأله النبي (صلّى الله عليه وآله): أتزوّجت؟
قال: بلى يا رسول الله.
ومرّت مدّة سأله بعدها النبي (صلّى الله عليه وآله): ماذا فعلت بزوجتك هذي؟
- طلّقتها أيضاً.
- هل رأيت منها سوءاً؟
- كلاّ، لم أر منها سوءاً.
فقال (صلّى الله عليه وآله): إنّ الله يبغض ويلعن الرجل الذي يحب أن يستبدل زوجته على الدوام، والمرأة التي تحب استبدال زوجها باستمرار.
وأخبروا النبي (صلّى الله عليه وآله) أنّ أبا أيوب الأنصاري قد صمّم على طلاق زوجته أم أيوب، ولما كان (صلّى الله عليه وآله) يعرف أم أيوب جيداً ويعلم أن طلاق أبي أيوب لزوجته ليس له مبرّر سليم، فقد قال (صلّى الله عليه وآله): (إنّ طلاق أم أيوب لحوب) أي خطيئة كبيرة.
ونقل الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله) أنه قال: (ليس أحب إلى الله تعالى من بيت يعقد فيه الزواج، وليس أبغض إليه من بيت يقع فيه الطلاق).
وقد أشار الصادق (عليه السلام) إلى أنّ القرآن إنّما أكثر من ذكر الطلاق وأكثر في الحديث عن تفاصيله؛ لأنّ الله تعالى عدو الانفصال والافتراق.
ونقل الطبرسي في مكارم الأخلاق عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: (تزوّجوا ولا تطلّقوا، لأنّ العرش يهتز عند الطلاق).
وقال الصادق (عليه السلام): (إنّ ابغض الحلال إلى الله الطلاق). (إنّ المطلاقين أعداء الله).
ولا يقتصر هذا على روايات الشيعة. بل روى أهل السنّة نظير ذلك. فقد جاء في سنن أبي داود عن الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: (ما أحلّ الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق).
وقد أشار الشاعر مولوي إلى القصة المعروفة لموسى (عليه السلام) وراعي الأغنام إلى هذا الحديث النبوي الشريف قائلاً:
تجنّب ما استطعت الفراق(1)
أبغض الأشياء عندي الطلاق
وممّا يشاهد في سيرة الأئمة المعصومين (عليه السلام) أنّهم كانوا يتجنّبون الطلاق بقدر الإمكان؛ لذا لم يكن يقع منهم الطلاق إلاّ نادراً فإن وقع، فلسبب وجيه ومعقول، فمثلاً: تزوّج الإمام الباقر (عليه السلام) من امرأة أحبّها، ثم انتبه إلى أنّ هذه المرأة (ناصبية) أي أنّها تعادي علي بن أبي طالب (ع) وقد ترعرع في قلبها بغضه فطلّقها الإمام. فسُئل الإمام (عليه السلام) لم طلّقتها وأنت تحبّها؟ فأجاب (عليه السلام): لم أشأ أن تكون بجانبي قطعة مشتعلة من جهنّم.
شائعة مفتعلة
وهنا يجب أن أشير باختصار إلى شائعة سطّرتها أيدي الخلفاء العباسيين الأثيمة واشتهرت بين عموم الناس وهي: أنّه قد شاع بين الناس وورد كثير من الكتب أنّ الإمام الحسن المجتبى الابن البار
____________________
(1) الشطر الأول فارسي في الأصل وهو: (تاتواني يامنه أندر فراق).
لأمير المؤمنين (عليه السلام) كان من الذين يتزوّجون كثيراً ويطلّقون. ولما كانت بداية هذه الشائعة قد جاءت بعد مئة عام من وفاة الإمام علي (عليه السلام) وانتشرت في كل مكان تقريباً ولم يحقّق محبّو الإمام (عليه السلام) في أصل هذه الشائعة وأنّ هذا العمل مبغوض في نظر الإسلام، وهو جزء من أخلاق العابثين والغافلين، ولا يليق أن ينسب إلى رجل كان من أعماله أن يحج ماشياً على قدميه وأنّه قسّم ثروته أكثر من عشرين مرّة بينه وبين الفقراء فأخذ نصفها الآخر، وكيف يليق أن ينسب ذلك إلى مقام الإمامة والطهارة.
وكما نعلم فإنّه إبّان انتقال الخلافة من الأمويين إلى العباسيين، كان بنو الحسن (عليه السلام) يتعاونون مع بني العباس. أمّا بنو الحسين والذين كان على رأسهم الإمام الصادق فقد امتنعوا عن مساعدة العباسيين لكن بني العباس مع أنّهم في أوائل أمرهم قد أظهروا الخضوع والتسليم لبني الحسن (عليه السلام) واعترفوا لهم بأنّهم أولى منهم، إلا أنّهم عادوا وقضوا على أكثرهم بالخيانة والقتل والسجن. ثم من أجل تمشية أمور خلافتهم، قام بنو العباس بالتشهير ببني الحسن (عليه السلام). ومن جملة الشائعات التي أطلقوها: أنّ أبا طالب الجد الأكبر لبني الحسن وعم رسول الله مات كافراً، وأمّا العباس العم الآخر النبي (صلّى الله عليه وآله) وأبو بني العباس فقد عاش ومات على الإسلام. ولذا فنحن أولاد عم النبي المسلم أجدر بالخلافة من أولاد الحسن الذين هم أولاد عم النبي الذي مات كافراً. وقد أنفقوا من أجل نسج القصص في هذا الباب أموالاً طائلة، كما أنّ مجموعة من أهل السنّة
- بتأثير هذه الإشاعات والإجراءات - أفتوا بكفر أبي طالب. ولكن طبقاً للتحقيقات التي قام بها مؤخّراً محقّقون من أهل السنّة في هذا المجال فقد وضح الأمر أكثر من ذي قبل.
الموضع الثاني الذي أشاعه بنو العباس عن بني الحسن هو أنّ جدّهم الحسن (عليه السلام) حين وصل إلى الخلافة بعد أبيه علي (عليه السلام)، وبسبب كونه رجلاً ماجناً مشغولاً بالنساء وشغله الشاغل التزوّج والتطليق، لم يطق المسؤولية، وقد تسلّم من معاوية - منافسه اللدود - أموالاً من أجل أن يتخلّى عن الخلافة له وانصرف هو إلى الزواج والطلاق.
ومن حسن التوفيق أنّ المحقّقين الفضلاء في العصور المتأخّرة قد أجروا تحقيقات في هذا الباب وشخّصوا مصدر هذا الكذب، ويظهر أنّ أوّل مَن سمع منه ذلك القاضي المنصوب من قِبل المنصور الدوانيقي، والذي كان المنصور قد أمره بنشر هذه الشائعة.
يقول أحد المؤرّخين: (إذا كان الإمام الحسن (عليه السلام) قد تزوّج من كل هؤلاء النسوة فأين ذرّيّته؟ ولماذا أولاده بهذه القلّة؟ والإمام لم يكن عقيماً من جهة، ولا كانت عادة إسقاط الجنين أو منع الحمل موجودة).
إنّني لأعجب لبعض الرواة الشيعة كيف يروون من جهة أنّ النبي الأكرم (صلّى الله عليه وآله) والأئمة الأطهار (عليه السلام) ضمن روايات كثيرة يذكرون أنّ الله عدو ولاعن للرجال المطلاقين، ثم يكتبون بعدها مباشرة أنّ الإمام الحسن (عليه السلام) رجل مطلاق. إن هؤلاء الأشخاص لم يفكروا في أنّهم إنّما
يختارون أحد ثلاثة طرق: فإمّا أنّهم يرون الطلاق أمراً جيداً وأنّ الله لا يبغض المطلاق. وإمّا أن يقولوا إنّ الإمام الحسن (عليه السلام) لم يكن مطلاقاً. وإمّا أن يروا أنّ الإمام الحسن (عليه السلام) - والعياذ بالله - لم يكن ملتزماً بتعاليم الإسلام. إلاّ أنّ هؤلاء السادة المحترمين يعتبرون الأحاديث الدالة على بغض الطلاق صحيحة من جهة ومن جهة ثانية يتواضعون لمقام الإمام الحسن (عليه السلام) المقدّس، ويرون من جهة ثالثة أنّ الإمام الحسن (عليه السلام) كان مطلاقاً. ويمرون بذلك دون إشارة أو نقد للأمر.
بل إنّ بعضهم قد بلغ به الأمر إلى حد أن يقول: إنّ أمير المؤمنين علي (عليه السلام) كان ناقماً على عمل ابنه هذا. فيعلو المنبر ليقول للناس لا تزوجوا ابني الحسن بناتكم لأنّه مطلاق. إلاّ أنّ الناس يجيبون: إنّنا نفخر بمصاهرة ابن رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، فإن شاء فليحتفظ ببناتنا وإلاّ فليطلّقهن.
وقد يتصوّر البعض أنّ موافقة الفتيات أو ذويهن على وقوع الطلاق كافٍ لزوال كراهة الطلاق، ظنّاً منهم أنّ بغض الطلاق ناشئ عن عدم موافقة الطرف الآخر، أمّا حين ترغب امرأة بنيل شرف الزوجية من رجل يكون محل فخرها لعدّة أيام، فلا مانع من الطلاق. لكنّ الأمر ليس كذلك، فإنّ رضا الفتيات وآبائهن بالطلاق لا يقلّل من كراهته شيئاً، فإنّ ما يريده الإسلام هو تقوية المؤسسة البيتية، أمّا رأي الزوجين في الانفصال فلا أثر له من هذه الناحية.
إنّ الإسلام حين يبغّض الطلاق
وينفّر منه، فليس ذلك من أجل إرضاء المرأة، بل إنّ رضا المرأة وذويها به لا يزيل هذا البغض.
إنّ الذي دعاني إلى طرح موضوع الإمام الحسن (عليه السلام) - عدا عن أنّ هذه التهمة التاريخية يجب أن ترفع في أول فرصة عن هذه الشخصية العظيمة - هو أنّ بعض الغافلين عن ذكر الله قد يعملون هذا العمل ثم يتخذون من الإمام الحسن سنداً لهم.
وعلى كل حال فإنّ الذي لا شك فيه هو أنّ الطلاق وافتراق الزوجين في حدّ ذاته مبغوض في نظر الإسلام ومنهي عنه.
لماذا لم يحرّم الإسلام الطلاق؟
وهنا يخطر سؤال مهم في الأذهان هو أنّ الطلاق إذا كان مبغوضاً إلى هذا الحد، وأنّ الله عدو للمطلاقين، فلماذا لم يحرّم الإسلام الطلاق؟ وما المانع في أن يكون الإسلام قد حرّم الطلاق وأجازه فقط في حالات خاصة ومعيّنة؟ وبتعبيرٍ آخر: ألم يكن من الأفضل لو أنّ الإسلام كان قد اشترط للطلاق شروطاً وأجاز الرجل أن يطلّق لدى توفّر تلك الشروط فحسب؟ وبما أنّ الطلاق مشروط، فإنّه سيحظى بلا ريب بجانب قضائي. ففي كل مرّة يريد رجل أن يطلّق زوجته، يكون مضطرّاً إلى مراجعة المحكمة لعرض أسباب ذلك، فإذا اقتنعت المحكمة بصحّة الأسباب أجازت الطلاق وإلاّ فلا؟.
من الناحية الأساسية، ما معنى جملة (أبغض الحلال إلى الله
الطلاق)؟ الطلاق كان حلالاً، فلا يكون بغيضاً، وإذا كان بغيضاً فليس بحلال، فالمبغوضية والحليّة لا يجتمعان. وبعد كل هذا، هل يحق للمجتمع - أي الهيئة التي تسمّى المحكمة وغير ذلك ممّا يمثّل المجتمع - أن يتدخّل في أمر هذا الطلاق الذي تكثرون من ذكر مبغوضيته ويحول دون الإسراع في إيقاعه من قِبل الرجل حتى يندم الرجل، أو يتبيّن للمجتمع - أي تلك الهيئة - أنّ الزواج موضوع البحث لا أمل في دوامه وسلامته وأنّ الأفضل فسخ العقد؟
(3) حق الطلاق
وصل بنا الحديث إلى أنّ الطلاق بغيض في نظر الإسلام، وأنّ الإسلام يريد أن يكون ميثاق الزواج متيناً ومحكماً. وهنا نطرح السؤال التالي: إذا كان الطلاق إلى هذا الحد بغيضاً وكريهاً فلماذا لم يحرّمه الإسلام؟ ألم يحرّم الإسلام كل عمل كريه كالخمر والميسر والظلم؟ فلماذا لم يحرّم الطلاق كليّاً ويجعل له مانعاً قانونياً؟ وفي الأساس، ما هذا المنطق الذي يذكر من أنّه حلال مبغوض؟ وإذا كان مبغوضاً فلماذا صار حلالاً؟ إنّ الإسلام يغضب من الرجل المطلاق من جهة وينفر من عمله، ومن جهة أخرى لا يضع مانعاً قانونياً يحول بينه وبين أن يطلّق زوجته حين يشاء، فلماذا؟ هذا السؤال في محلّه فجميع الأسرار تكمن هنا، إنّ السر الأساس في الأمر هو أنّ الزوجية والحياة
المشتركة علاقة طبيعية وليس وضعية، وقد وضعت لها في الطبيعة قوانين خاصة. وهذا العقد يختلف عن جميع العقود الاجتماعية الأخرى (من قبيل البيع والإجارة والمصالحة والرهن والوكالة وغيرها) بإنّ جميع ما ذكر عقود اجتماعية وضعية بحتة، وليس للطبيعة والغريزة دخل فيها، ولم تضع الطبيعة والغريزة قانوناً لها، بخلاف عقد الزواج الذي يجب أن يقوم بناءً على رغبة طبيعية من قِبل الطرفين ذات تركيبة خاصة.
فلا عجب إذن من أنّ لعقد الزواج مقرّرات خاصة تختلف عن بقيّة العقود والعهود.
قوانين الفطرة فيما يخصّ الزواج والطلاق
إنّ القانون الطبيعي في المجتمع المتحضّر هو قانون الحرية والمساواة، وجميع مقرّرات المجتمع يجب أن تُبنى على أساس من هذين المبدأين لا غير. هذا بخلاف عقد الزواج وضعت له في الطبيعة - عدا هذين المبدأين - قوانين أخرى أيضاً لا مناص من مراعاتها. فكما تجب مراعاة هذه القوانين في أوّل ووسط الأمر، أي لدى الزواج (وذكرنا قسماً منها تحت عنوان الخطبة والمهر والنفقة في موضوع الفروق بين المرأة والرجل) فكذلك تجب في الطلاق - الذي هو نهاية الأمر - مراعاة هذه القوانين الطبيعية. فلا فائدة من الوقوف بوجه الطبيعة كما قال الكسيس كارل: (إنّ قوانين الحياة والمعيشة، كقوانين الكواكب
، قاسية لا ترحم ولا يمكن مقاومتها).
الزواج وحدة واتصال، والطلاق فراق وانفصال. وفي الوقت الذي وضعت الطبيعة قانون البحث عن الزوج واتصال المرأة بالرجل بالصورة التي يتقدم فيها شخص طالباً صحبة آخر ويقوم الآخر بالتراجع من أجل اجتذاب قلبه ومخادعته، وجعل قصد أحدهما هو الاستيلاء على الآخر وقصد الآخر الاستيلاء على قلب الأول، وفي الوقت الذي بنت الطبيعة الزواج على الحب والوحدة والتعاطف لا على المساعدة والصداقة، وفي الوقت الذي جعلت أساس العائلة قائماً على مركزية الجنس الأظرف ودوران الجنس الخشن حوله، فكذلك لابد أن يكون الفراق والانفصال وانهيار هذه المؤسسة وانفراط هذه المنظومة تابعاً - شئنا أم أبينا - للمقرّرات الطبيعية الخاصة.
في المقالة الخامسة عشرة نقلنا عن أحد العلماء قوله: (إنّ طلب الزواج عبارة عن هجوم للاحتلال من قِبل الرجال، وتراجع من أجل اجتذاب القلوب والفتنة لدى النساء. ولما كان الرجل - في طبعه - حيواناً مفترساً، فعمله الهجوم والايجابية، والمرأة بالنسبة للرجل جائزة يريد الفوز بها، فطلب الزوجة حرب وكفاح والزواج صحبة واقتدار).
إنّ العقد المبتنى على الحق والوحدة لا التعاون والصداقة، لا يمكن أن يقبل الإكراه والإلزام، فبالإكراه القانوني يمكن أن تلزم شخصين بالتعاون فيما بينهما واحترام عقد على أساس العدالة والاستمرار سنين
طويلة على هذه الشاكلة. لكن لا يمكن أن نكلّف - بقوّة القانون - شخصين لكي يحبّا بعضهما ويخلصا تجاه كل منهما، ثم يفدي كل منهما الآخر بنفسه، ويرى كل منهما سعادته الذاتية في سعادة صاحبه.
فإذا أردنا أن نصنع علاقة بين شخصين على هذه الصورة فيجب أن نتخذ غير الإجبار القانوني تدابير عملية واجتماعية أخرى.
إنّ التركيبة الطبيعية للزواج، والتي بنى الإسلام قوانينه على أساسها، هي أن تغدو المرأة محبوبة ومحترمة داخل المنظومة العائلية. فإذا حدث ما يؤدّي إلى نزول المرأة عن هذا المقام وانطفأت شعلة حب الرجل لها، وأصبح زوجها غير راغب فيها، فقد هدم الصرح والركن الأساس للعائلة، أي أنّ مجتمعاً طبيعياً قد انهار بحكم الطبيعة. إنّ الإسلام ينظر إلى مثل هذا الوضع نظرة أسى وأسف، لكنّه حين يشاهد انهيار الأساس الطبيعي لهذا الزواج لا يسعه أن يفرض بقاءه من الناحية القانونية.
إنّ للإسلام مساعي وتدابير خاصة ابتدعها للإبقاء على الحياة العائلية من الناحية الطبيعية، أي أن تبقى المرأة في مقام المحبوبة والمطلوبة، والرجل في مقام الطالب والمحب وتقديم الخدمة لها.
وتقضي وصايا الإسلام بأن تتزيّن المرأة لزوجها كمسألة حتمية، وتتفنّن في إظهار ما يحبّبها إليه، وتشبع رغباته الجنسية، ولا تسبّب له العُقَد والمشاكل النفسية بصدّ هذه الرغبات، كما تقضي بأن يكون الرجل
بدوره رفيقاً لزوجته يبدي لها حبّه وعشقه ولا يخفي عنها محبّته. كذلك فإنّ الإسلام اتخذ تدابير من شأنها أن تجعل البيت محيطاً للممارسات الجنسية، وجعل المجتمع الكبير محيط عمل وفعّالية لا مؤسسة للممارسة الجنسية، فبنى توصياته على أن تكون لقاءات النساء والرجال خارج حدود الزوجية نظيفة وطاهرة كأمر لازم وحتمي، كل ذلك من أجل حماية المجتمعات الأُسرية من خطر الانهيار.
المكانة الطبيعية للرجل في حياته الأُسرية
إنّ أقصى درجات الإهانة والاحتقار - من وجهة نظر الإسلام - تكمن في مخاطبة الرجل للمرأة قائلاً: لا أحبّك، إنّني أشمئز منك، ثم يأتي القانون ليبقي المرأة بالقوّة والإكراه في بيت ذلك الرجل. إنّ القانون يستطيع أن يرغم المرأة بالقوّة على البقاء في بيت هذا الرجل، لكنّه لا يستطيع أن يحتفظ لها بمكانتها الطبيعية في محيط الزوجية وهي مكانة المحبوبية والمركزية. إنّ القانون قادر على أن يجبر الرجل على الاحتفاظ بالمرأة ودفع نفقاتها، وغير ذلك، لكنّه غير قادر على أن يجعل من الرجل مضحّياً من أجل تلك المرأة وكوكباً يدور في فلكها. وعلى هذا الأساس، ففي الوقت الذي تنطفئ فيه شعلة حب الرجل، يكون الزواج قد مات من الناحية الطبيعية.
وهنا يطرأ سؤال آخر هو: ماذا ستكون النتيجة لو أنّ هذه الشعلة انطفأت من جانب المرأة؟ هل ستبقى الحياة العائلية مستمرّة عندما
يموت حب المرأة للرجل أم هذه ستموت هي الأخرى؟ فإن بقيت مستمرّة فما الفرق حينئذٍ بين المرأة والرجل لكي يكون موت حب الرجل موجباً لانتهاء حياة الأُسرة ولا يكون موت حب المرأة كذلك؟ وإذا كان موت حب المرأة ينهي كذلك حياة البيت، فيجب عندها أن ننهي الزواج عندما يموت حب المرأة لزوجها ونمنحها كالرجل حق الطلاق.
الجواب هو أنّ استمرار حياة الأسرة متعلّق بالحب المتبادل من الطرفين لا من طرف واحد. والذي نشير إليه هنا إنّما هو التباين بين نفسيّة المرأة ونفسية الرجل في هذا المجال، وقد بيّنا ذلك في المقالات السابقة استناداً إلى تحقيقات العلماء.
إنّ الطبيعة قد صاغت علاقة الزوجين بشكل تكون فيه المرأة متجاوبة مع الرجل؛ فعلاقة وحب المرأة الأصيلين الثابتين إنّما يأتيان على شكل ردّ فعل لتعلّق الرجل بالمرأة واحترامه لها. وعلى هذا الأساس، فإنّ علاقة المرأة بالرجل ما هي إلاّ نتيجة لعلاقة الرجل بالمرأة ومرتبطة بها.
إنّ الطبيعة قد سلّمت مفتاح محبّة الطرفين بيد الرجل فإن هو أحبّ المرأة وظلّ وفيّاً لها، أحبّته هي أيضاً ووفت له، وممّا لاشك فيه أنّ المرأة أوفى طبيعة من الرجل، وغدر المرأة ردّ فعلٍ لغدر الرجل.
والطبيعة قد وضعت مفتاح الفسخ الطبيعي للزواج بيد الرجل كذلك،
أي أنّ الرجل إذا لم يحب المرأة ولم يف لها يكون قد تسبب في برود حبها. على العكس ممّا لو برد حب المرأة وفترت عاطفتها فإنّها ستزيد حب الرجل اشتعالاً في بعض الأحيان؛ ولهذا فإنّ فتور حب الرجل يجر إلى فتور حب الطرفين، أمّا فتور حب المرأة فلا يجر إلى فتور حب الطرفين. وبرود وانطفاء حب الرجل يؤديان إلى موت الزواج وانتهاء حياة الأسرة، أمّا برود وانطفاء حب المرأة للرجل فيجعل الزواج أشبه بمريض مشرف على الموت إلاّ أنّ الأمل في شفائه قوي، فإذا ظهر الفتور من المرأة وكان الرجل عاقلاً وفيّاً، استطاع بإظهار حبّه وعطفه أن يفوز ثانية بحبّها. وهذا الأمر يشكّل إهانة له إذ يمكنه الاحتفاظ بمحبوبه النافر بقوّة القانون حتى يستأنسه بالتدريج، أمّا بالنسبة للمرأة فتعد محاولتها الاحتفاظ بحاميها وعاشقها بقوّة وإكراه القانون إهانة لا يمكن تحمّلها.
وبالطبع، إنّ هذا صحيح حين لا يكون سبب عزوف المرأة سوء أخلاق الرجل وظلمه، فإذا بدأ بالاعتداء والظلم ونفرت منه المرأة بسبب ظلمه فتلك مسألة أخرى سنبحثها حين نتعرّض لبحث المسألة الثانية، وهي الامتناع اللئيم عن الطلاق، وسنذكر كيف أنّه لن يسمح للرجل أن يستغل صلاحيته ويحتفظ بالزوجة من أجل الإضرار بها والاعتداء عليها.
وعلى كل حال: فإنّ الفارق بين المرأة والرجل، يكمن في أن
الرجل محتاج إلى شخص المرأة، والمرأة محتاجة إلى قلب الرجل. من هذا المنطلق تصبح حماية الرجل ورقة قلبه على درجة عالية من الأهمّيّة بالنسبة للمرأة تجعل الزواج بدونهما أمراً يمكنها احتماله.
رأي عالمة نفسانية
في العدد 113 من مجلة (زن روز) نشرت مقالة من كتاب (علم نفس الأُمّهات) تأليف سيدة فرنسية اسمها (بياترس ماريو)، هذه السيدة - كما جاء في المقالة - طبيبة في علم النفس وعالمة نفسانية في مستشفيات باريس، وهي نفسها أم لثلاثة أولاد.
في جوانب من هذه المقالة، شرحت بتفصيل احتياجات المرأة إلى حب وحنان زوجها إبّان حملها وولادتها، قالت: (منذ شعور المرأة بأنّها قد أشرفت على الأمومة تبدأ بتفحّص جسمها وإكثار النظر إليه وشم رائحته خصوصاً إذا كان هذا هو طفلها الأول. وهذه الحالة من التفحص والتدقيق تستمر بنشاط كما لو كانت المرأة غريبة على نفسها، وتريد أن تكتشف ذاتها، فإذا أحسّت بأول ضربات طفلها في بطنها، تبدأ بالإنصات إلى كل صوت في بدنها ويمنحها وجود مخلوق آخر في جسمها سعادة وسروراً كبيرين يدفعانها إلى الانزواء التدريجي والميل إلى الخلوة بنفسها وقطع علاقتها بالعالم الخارجي، إذ إنّها تريد أن تخلو إلى طفلها الذي لم يأت إلى الدنيا بعد...
إنّ الرجال في أثناء مدّة حمل زوجاتهم مكلّفون بإنجاز واجبات
مهمّة جداً، لكنّهم - للأسف يتخلّون دائماً عن أدائها. إنّ أُمّ المستقبل تحتاج إلى الشعور بأنّ زوجها يتفهّمها ويحبّها ويساندها، وبغير ذلك فإنّها حين ترى بطنها قد ارتفع، وجمالها قد تغيّر، والقيء والغثيان قد استوليا عليها وهي خائفة من الولادة، فستعزو كل مصائبها إلى عمل زوجها الذي كان السبب في حملها.. إنّ الرجل يجب أن يكون إلى جانب زوجته في أشهر الحمل أكثر من ذي قبل فالأُسرة تحتاج إلى أب رحيم يمكن للزوجة والأولاد أن يحدّثوه عن جميع مشاكلهم وآمالهم، وحتى إذا كانت أحاديثهم بلا معنى أو مملّة فإنّ الحامل تحتاج كثيراً إلى أن تتحدّث إلى زوجها حول طفلها القادم. إنّ اكتمال فخر المرأة وسعادتها في أن تصبح أمّاً، وفي الوقت الذي تشعر فيه أو زوجها غير مهتم بطفلها الذي سيفد إلى الدنيا عمّا قريب سيتحوّل هذا الفخر والسعادة إلى شعور بالحقارة واليأس والاشمئزاز من الأُمومة، ويصبح الحمل بالنسبة لها (احتضاراً). وقد ثبت أنّ مثل هؤلاء النساء لا يتحمّلن مشاكل الحمل إلاّ بمعاناة شديدة.. فعلاقة الأم بالطفل ليست علاقة ثنائية بل هي علاقة ثلاثية، أركانها: الأم والأب والطفل. وحتى إذا كان الأب غائباً (كما لو كانت مطلّقة) فإنّه يلعب دوراً أساسياً في التأثير على حياة الأم الداخلية، وفي خيالها وتصوّراتها).
كان هذا حديث سيدة عالمة، متخصّصة في علم النفس كما هي أم.
البناء الذي قام على أساس العواطف
والآن عليكم أن تحكموا كيف يمكن لمخلوق يحتاج إلى عطف ومحبّة وحماية وحنان مخلوق آخر إلى هذه الدرجة، وهو مستعد لعمل أي شيء إذا وجد هذا العطف والحنان، والذي لا يمكنه بدون هذا العطف أن يفهم حتى طفله بصورة صحيحة، هذا الموجود الذي يحتاج إلى قلب ومشاعر الموجود الآخر وليس إلى وجوده فحسب، كيف يمكن للقانون أن يرغمه على الالتحام بذلك الموجود الآخر المسمّى بـ (الرجل)؟
أليس من الخطأ أن نقوم من جهة بتوفير مسوّغات المجون وفتور علاقة الرجال بزوجاتهم ووسائل العبث والانحطاط الجنسي يوميّاً وباستمرار، ثم نحاول أن نبقي بقوّة القانون على صلة الزوجات بأزواجهن، أو كما يقولون أن نلصقهن بلحاهم - حسب المثل المعروف - لقد عمل الإسلام على أن يجعل الرجل يرغب في زوجته تلقائياً، وأن يحبها ذاتياً، ولم يعمل في يوم من الأيام على أن يلصقها به عنوة.
وعلى العموم، ففي كل وقت يكون الحب والإرادة والإخلاص محور القضية، وأساس العمل وركنه، فلن يكون هناك إكراه بقوّة القانون، من الممكن أن يكون ذلك مجالاً للتأسّف إلاّ أنّه لن يكون مجالاً للإجبار والإلزام والإكراه. أذكر بهذه المناسبة مثالاً: كلّنا نعلم أن عدالة الإمام في صلاة الجماعة واعتقاد المأمومين بتلك العدالة شرط في صحّة الصلاة، وارتباط واجتماع الإمام والمأمومين هو ارتباط واجتماع قائم على
أساس عدالة الإمام وإرادة ومحبة وأخلاق المأمومين. فالقلب والمشاعر هما ركنا هذا الارتباط وأمّا الاجتماع فهو الأساس؛ وعلى هذا، هذا الاجتماع والارتباط لا يمكن أن يكونا بالإجبار والإكراه، ولا يمكن للقانون أن يضمن بقاءهما واستمرارهما، فإنّ المأمومين متى ما تحوّل حبّهم وإخلاصهم وإرادتهم عن إمام جماعتهم، انهار أساس هذا التحوّل في محلّه أو في غير محلّه. ولو افترضنا أنّ إمام الجماعة كان يتمتع بأعلى درجة من العدالة والتقوى والصلاح، فإنّه - مع ذلك - لا يستطيع أن يجبر المأمومين على الاقتداء به. ويكون مضحكاً جداً أن يتقدّم إمام جماعة إلى المحكمة شاكياً الناس، قائلاً: لم يحبونني؟ ولم لا يعتقدون بي؟ وأخيراً، لم لا يقتدون بي؟ بل إنّ منتهى الإهانة التي لا تليق بمقام إمام الجماعة نفسه هو أن يجبر - هو نفسه - الناس بالقوّة على الاقتداء به.
وكذلك العلاقة بين الناخبين والنوّاب، فهذه العلاقة أيضاً ممّا يجب أن تقوم على أساس الحب والاعتقاد والإيمان. فالقلب والمشاعر هما ركنا هذا الارتباط والعلاقة. ويجب أن يكون الناس مقتنعين وراغبين ومؤمنين بالنائب الذي ينتخبونه، فإذا رفض الناس أن ينتخبوا شخصاً فإنّ هذا الشخص لا يمكنه ولا يليق به أن يجبر الناس على التصويت إلى جانبه مهما كان الناس على خطأ وكان هو في منتهى الصلاح واللياقة وحائزاً على الشروط المطلوبة؛ ذلك أنّ طبيعة الانتخاب والتصويب لا تنسجم مع الإجبار والإكراه، ولا يستطيع هذا الشخص - بناءً على
حيازته على الشروط اللازمة - أن يشكو للمحكمة إعراض الناس عن انتخابه بالرغم من لياقته. إنّما الذي يجب أن يتم في مثل هذه الحالات هو رفع المستوى الفكري للناس؛ فتربية الناس بصورة سليمة تقودهم - حين رغبتهم في أداء فرائضهم الدينية - إلى البحث عن العدول الحقيقيين والرغبة إليهم بإمامتهم ويقتدون بهم، وحين يريدون أن ينجزوا مهمّتهم الاجتماعية يبحثون عن الأفراد الصالحين ويصوّتون إلى جانبهم عن حب وإرادة، وإذا حدث أحياناً أن غيّر الناس نظرتهم ومنحوا ثقتهم لشخص آخر بدون مبرّر سليم، فذلك ما يدعو إلى التأسّف والتأثّر، لا إلى الإجبار والإكراه والتدخّل بالقوّة.
والواجب العائلي يشبه الواجب الديني والاجتماعي تماماً. إذاً المهم أن نفهم أنّ الإسلام يرى الحياة العائلية مجتمعاً طبيعياً قد وضع له تركيبه شرط لا يقبل النقض.
إنّ أعظم معاجز الإسلام هي تشخيص هذه التركيبة، وأنّ الذي حال بين العالم الغربي وبين التغلّب على المشكلات الأُسرية - التي لا تزال تزداد يوماً بعد يوم - هو عدم الاهتمام بهذه النقطة. لكن التحقيقات العلمية - لحسن الحظ - مستمرة في الكشف عن هذه الأمور. وأنا الآن أرى إقبال عالم الغرب تدريجياً - على تبنّي المبادئ الإسلامية للقواعد العائلية على ضوء ما يكشفه العلم - إقبالاً واضحاً كالشمس.
وبالطبع فإنّني لا أرى التعليمات الإسلامية المتينة والنيّرة على أنّها وما هو معروف (بالتعاليم الإسلامية) بين الناس اليوم سواء.
ما يحكم بناء الأُسرة شيء أكثر من المساواة
إنّ ما يبهر العالم الغربي في الوقت الحاضر هو مسألة (المساواة): بالرغم من أنّ الإسلام قد حلّ هذه المسألة قبل أربعة عشر قرناً. ففي الأمور العائلية ذات النظام الخاص يوجد ما هو فوق المساواة. إنّ الطبيعة قد وضعت وتضع للمجتمع المدني فقط قانون مساواة، أمّا للمجتمع العائلي فقد وضعت كذلك قوانين أخرى. إنّ المساواة وحدها لا تكفي لتنظيم العلاقات الإسلامية، بل يجب معرفة كل القوانين الطبيعية الأخرى في مجال المجتمع الأُسري.
المساواة في الفساد
ممّا يؤسف له أنّ كلمة المساواة - بسبب التكرار والإيحاء المتجدّد - قد فقدت خاصيتها الأساسية، فقليل هم الذين يفهمون - من كلمة المساواة - المساواة في الحقوق، أمّا الكثيرون فيتصوّرون أنّ المساواة لو تحقّقت في مجال واحد فقد تحقّق المطلوب، ففي نظر هؤلاء الجهلة أنّ الرجال كانوا في السابق يعتدّون بأقوالهم ولا يقيمون لكلام النساء وزناً ولا يقبلون أقوالهن حتى لو كانت حقّاً ومطابقة للواقع. أمّا اليوم وبعد أن انعكس الأمر فقد تحقّق المطلوب؛ إذ حصلت المساواة في اعتداد كل من المرأة والرجل برأيه. وفي السابق كان ما يقرب من
عشرة بالمئة من الزيجات تنتهي بالطلاق من جانب الرجال، أمّا اليوم فتنتهي أربعون بالمئة من الزيجات في بعض بلاد العالم بالطلاق والذي يقع نصفه من جانب النساء، إذاً فلنحتفل ولنفرح فإنّ المساواة قد تحقّقت كاملة. في السابق كان الرجال فقط هم الذين يخونون زوجاتهم، وكانوا هم فقط يفتقدون العفّة والتقوى، أمّا اليوم فقد أصبحت النساء - بحمد الله - تخون أزواجها. ولا تتقيّد بعفّة ولا تقوى، فما أحسن هذا؟ لتحيا المساواة، والموت للفوارق. في السابق كان الرجال مثال القسوة، وبالرغم من كونهم آباء لمجموعة من الأطفال المحبوبين فإنّهم يتركون الزوجة والطفل ليجروا خلف عشيقة جديدة، واليوم تقوم النساء المتزوجات - بعد مرور سنوات على الزواج وبعد إنجاب مجموعة من الصغار - بهجر بيوتهن بقساوة عجيبة ويجرين خلف الهوى على إثر تعارف تمّ في أثناء حفلة راقصة مع رجل آخر. فما أحسن هذا! لقد وقفت المرأة مع الرجل على بساط واحد وتحقّقت المساواة.
هذا في الوقت الذي يجب علينا أن نداوي أمراض المجتمع العديدة، وبدلاً من إصلاح نقاط الضعف لدى الرجال والنساء، وإحكام أُسس المؤسسة العائلية، ترانا نسعى يوماً بعد يوم من أجل زعزعة أُسس هذا الكيان وإضعافه، ونشغل أنفسنا بالرقص والدبك، ونحن بحمد الله سائرون نحو تحقيق المساواة. لكنّنا نجد المرأة الآن تكاد تسبق الرجل في الفساد والانحراف والقسوة.
لقد أصبح الآن واضحاً: لماذا لم يضع الإسلام مانعاً قانونياً يحول دون إجراء الطلاق، بالرغم من بغضه واشمئزازه منه، فهل صار واضحاً ما هو معنى أبغض الحلال؟ وكيف يكون الشيء حلالاً وفي الوقت ذاته في منتهى البغض والكراهة؟
(4) حق الطلاق
تبيّن من البحوث السابقة أنّ الإسلام يعارض الطلاق وانهيار العائلة، ويراهما عدوّين له، وقد اتخذ مختلف التدابير الأخلاقية والاجتماعية من أجل صيانة هذه المؤسسة من خطر الانحلال، وتوسّل بمختلف الوسائل والطرق من أجل الحيلولة دون وقوع الطلاق، واستعمل في ذلك أنواع الأسلحة، ماعدا سلاح القوّة وسلاح القانون.
إنّ الإسلام يعارض استعمال القوّة وسلاح القانون من أجل منع الرجل من إيقاع الطلاق وإبقاء المرأة في بيت الرجل رغماً عنه، إنّه يرى ذلك غير منسجم مع المقام والموقع الذي يريده للمرأة في المحيط العائلي. فإنّ الركن الأساس في حياة العائلة هو الإحساسات والعواطف، وأنّ الذي يجب أن يجتذب الإحساسات والعواطف الزوجية لينشرها على أطفاله بدوره هو المرأة، وأنّ انطفاء شعلة المشاعر الزوجية عند الرجل تجاه زوجته يجعل الجو العائلي بارداً كئيباً، وحتى مشاعر الأمومة لدى أيّ امرأة تجاه أطفالها لها علاقة وثيقة بإحساسات
زوجها تجاهها، وكما تقول السيدة (بياتريس ماريو) التي نقلنا جانبا من حديثها في المقالة السابعة: إنّ إحساسات الأمومة ليست غريزية بالمعنى الذي يجعلها ثابتة المقدار في جميع الأحوال، وغير قابلة للزيادة والنقصان، بل إنّ لمقدار ما تتمتّع به المرأة من عواطف زوجها تجاهها أكبر الأثر على مشاعر الأمومة التي تحسّها تجاه أطفالها.
وبالنتيجة: فإنّ وجود المرأة يجب أن يتلقّى من وجود الرجل عواطف وإحساسات معيّنة ليمكّنها من أن تفيض على أطفالها من هذا المنبع الغني عطفاً وحناناً.
إنّ الرجل كالسهل بين الجبال، والمرأة كالنبع، والأولاد بمنزلة الزهور والنباتات. إنّ النبع بحاجة إلى أن يجذب الأمطار الساقطة على الجبال ليصوغها ماءً زلالاً صافياً يفيضه على الزهور والنباتات والزرع فتزهو وتنتعش. فإذا لم تهطل الأمطار على الجبال، أو كان السهل عاجزاً - لسبب ما - عن امتصاص مائها؛ جفّت العين، وقضت على الزهور والنبات.
وكما أنّ أساس حياة السهل مرهونة بالأمطار، وخاصة الأمطار الساقطة على قمم الجبال، فإنّ حياة الأُسرة مرهونة بإحساسات وعواطف الرجل تجاه المرأة؛ إذ بهذه العواطف تصفو وتزهو حياة المرأة والأطفال.
فإذا كان لإحساسات وعواطف الرجل تجاه المرأة مثل هذا التأثير
في روح الحياة العائلية، فكيف يمكن أن يستعمل القانون كسلاح وعصا ضد الرجل؟
إنّ الإسلام يعارض بشدّة الطلاق الغادر، وهو أن يقوم رجل بتسريح زوجته - بعد توقيع عقد الزواج وأحياناً بعد مضي مدة من الحياة المشتركة بينهما - بسبب هوى امرأة جديدة أو أي هوىً آخر. لكن حلّ ذلك في نظر الإسلام لا يكون بإجبار (الغادر) على الاحتفاظ بالزوجة؛ لأنّ هذا الاحتفاظ لا ينسجم مع القانون الطبيعي للحياة العائلية.
وإذا أرادت المرأة أن تعود إلى دار زوجها بقوّة القانون والقضاء، فإنّها تستطيع احتلال البيت احتلالاً عسكرياً، لكنّها لن تصبح سيدة العائلة ولا واسطة لجذب حنان الزوج وعكسه على الأطفال، كما لن تتمكّن من إشباع حاجتها الوجدانية إلى الحب والحنان. إنّ الإسلام قد سعى إلى القضاء على ما ينافي الشهامة والطلاق القائم على ذلك في سلوك الرجل، كما سعى إلى أن يقوم الرجال بشهامة وكرم برعاية النساء وخدمتهن. لكنّه لا يرضى - لنفسه كمشرع ولا للمرأة كمركز للمنظومة العائلية وواسطة لاجتذاب وبث الإحساسات الحنونة - أن يحتفظ بالمرأة بالقوّة والإكراه إلى جانب رجل غادر.
إنّ ما فعله الإسلام هو بالضبط عكس ما فعله ويفعله الغرب وأتباعه، فهو يكافح عوامل اللؤم والغدر والاستغراق في الأهواء، لكنّه
غير مستعد لإلصاق المرأة بالقوّة برجل لئيم غادر، بينما يزيد الغربيون وأتباعهم في عوامل اللؤم والغدر والاسترسال يوماً بعد يوم ثم يسعون إلى إلصاق المرأة بالقوّة برجل غادر لئيم...
أرجو أن تصدّقوا أنّ الإسلام مع كونه لم يجبر اللئام من الرجال على الاحتفاظ بالنساء، بل تركهم أحراراً ووجّه مساعيه كلها من أجل إحياء الروح الإنسانية والشهامة، قد استطاع من الناحية العملية أن يحد من حالات الطلاق الغادر. بينما الآخرون الذين لا يراعون هذه الجوانب الأخلاقية ويطلبون السعادة عن طريق القوّة والحرب لم يوفقوا كثيراً في هذا المجال. فبغضّ النظر عن حالات الطلاق التي تحصل بطلب من النساء نتيجة عدم الانسجام، أو بسبب ما تسمّيه مجلة (نيوزويك) طلب المتعة من قبل النساء فإنّ عدد حالات الطلاق التي تحصل نتيجة لمجون الرجال عندهم تزيد كثيراً عمّا يقع عندنا لهذا السبب نفسه.
طبيعة الصلح العائلي تختلف عن باقي أنواع الصلح
ممّا لا شك فيه أنّه يجب أن يكون بين الرجل والمرأة سلام وصلح، إلاّ أنّ الصلح والسلام اللذين يجب أن يسودا الحياة الزوجية هما غير الصلح والسلام اللذين يجب أن يكونا بين عمّال في معمل، أو شريكين، أو بين جارين أو بين دولتين مشتركتين في الحدود.
إنّ الصلح والسلام في الحياة الزوجية نظير الصلح والسلام الذي
يجب أن يسود العلاقة بين الآباء والأمهات من جهة وبينهم وبين أولادهم من الجهة الأخرى، وهو يعدل التسامح والفداء، والاهتمام بالمصير المشترك، وكسر جدار الإحساس بغربة كل منهما عن الآخر، فيرى كل من الطرفين سعادته في سعادة الآخر وشقاءه في شقائه. هذا بخلاف الصلح والسلام بين زميلين في العمل أو شريكين أو جارين أو دولتين جارتين.
فمثل هذا الصلح بمثابة عدم تعرّض وعدم اعتداء طرف على حقوق الطرف الآخر. وبين الدولتين المتخاصمتين، يكفي أيضاً أن يكون هناك (صلح مسلّح). فإذا تدخّلت قوة ثالثة واحتلت الشريط الحدودي بين الدولتين وحالت دون اصطدام قوات الدولتين ببعضهما فقد حلّ الصلح، فالصلح السياسي ليس شيئاً أكثر من عدم التعرض وعدم الاشتباك.
لكنّ الصلح العائلي غير الصلح السياسي، ففي الصلح العائلي لا يكفي عدم تعدي أحد الطرفين على حقوق الآخر، فإنّ الصلح المسلح لا يحل المشكلة هنا، بل يلزمهم هنا شيء أسمى وأكثر أساسية، إذ يجب أن يتحقّق الاتحاد والاندماج والتمازج الروحي، كما يلزم في الصلح بين الآباء والأبناء شيء أسمى من عدم التعرّض. ممّا يؤسف له أنّ عالم الغرب - ولأسباب تاريخية أحياناً وأحياناً جغرافية - بعيد على العواطف (حتى في محيط الأُسرة). والصلح العائلي في نظر الرجل
الغربي لا يختلف في شيء عن الصلح السياسي أو الاجتماعي. فهو كما يقر السلام بتمركز قوّة على الحدود بين الدولتين يريد أن يقرّه بتمركز قوّة المحكمة على حدود حياة المرأة والرجل، غافلاً عن أنّ الحياة العائلية مبنية على أساس الوحدة ورفض القوّة الخارجية، وإزالة الحدود.
وأتباع الغرب - بدلاً من مواجهة الغرب بأخطائه في المسائل العائلية والتباهي بأصالة ما عندهم - صبغوا أنفسهم بصبغته حتى عادوا لا يعرفون أرجلهم من رؤوسهم ولا يعرفون أنفسهم. إلاّ أنّ هذا الضياع الذاتي سوف لا يستمر طويلاً، وليس ذلك اليوم - الذي يسترد فيه الشرق شخصيته ويحطّم قيود عبوديته للغرب، ويعتمد على فكره المستقل وفلسفته المستقلّة في الحياة - ببعيد.
وهنا لابدّ من ذكر أمرين:
1 - الإسلام يرحّب بكل ما يصرف الرجل عن الطلاق
قد يفهم بعض الناس من كلامنا السابق أنّنا نقصد أنّه يجب ألاّ يوضع أي عائق يعوق الرجل عن الطلاق، وأن يفسح له في المجال إن هو رغب فيه. كلاّ، ليس كذلك، إنّ ما قلناه هو أنّ الإسلام لا يحبّذ استعمال قوّة القانون لمنع الرجل من إيقاع الطلاق، بل يرحّب بكل ما يصرف الرجل عنه، وقد وضع للطلاق - عامداً - شروطاً تستوجب بطبيعتها تأخير الطلاق، وغالباً ما تؤدّي إلى الانصراف عنه.
إذ علاوةً على أنّ الإسلام قد أوصى مجري صيغة الطلاق والشهود وغيرهم بأن يبذلوا مساعيهم الجدّية لصرف الرجل عن فكرة الطلاق، فقد جعل صحّة وقوع الطلاق قائمة على حضور شاهدين عادلين، وهذان الشاهدان سيعملان بكل طاقتهما - وبما يتمتعان به من عدالة وتقوى - على إيجاد الصلح والصفاء بين المرأة والرجل.
أمّا ما هو معمول به هذه الأيام من إيقاع صيغة الطلاق بحضور شخصين عادلين لم يسبق لهما أن رأيا الزوجين ولا عرفاهما، إنّما سمعا باسميهما فقط، فبحث آخر، لا علاقة له بنظرة وهدف الإسلام. فالمتعارف بيننا هو أن يحضر مجري الطلاق شاهدين عادلين ويذكر أمامهما اسم الزوج والزوجة، فمثلاً يقول: الزوج أحمد والزوجة فاطمة، وأنا قد طلقت الزوجة وكالة عن الزوج. ولكن مَن هو أحمد ومَن هي فاطمة؟ وهل سبق لهذين الشاهدين العادلين اللذين يستمعان إلى صيغة الطلاق أن رأيا الزوجين؟ ولو طلبا يوماً للشهادة، فهل يستطيعان أن يشهدا قائلين: نعم قد وقع بحضورنا طلاق هذين الزوجين بالذات؟ طبعاً لا، إذاً فأيّ شهادة هذه؟ أنا لا أدري.
وعل كل حال، فمن الأمور التي توجب انصراف الرجل عن الطلاق شرط حضور شاهدين عدلين إذا أُريد إجراؤه بصورة صحيحة. إنّ الإسلام عند الزواج - الذي هو بداية الاتفاق - لم يشترط حضور شاهدين عدلين؛ اذ لم يرد أن يؤخّر عمل الخير، لكنّه من أجل الطلاق -
الذي هو إنهاء للاتفاق - اشترط حضور الشاهدين العدلين.
كذلك فإنّ الإسلام عند الزواج لم يعتبر وجود العادة الشهرية عند المرأة مانعاً من إيقاع العقد، بينما اعتبرها مانعاً من وقوع الطلاق، مع العلم أنّ العادة الشهرية عند المرأة لكونها تمنع الاتصال الجنسي بين المرأة والرجل، فهي متعلّقة بالزواج لا بالطلاق الذي هو انفصال وفراق المرأة عن الرجل حيث لا صلة بينهما بعد ذلك. وعلى هذا الأساس، كان يجب أن يحرّم الإسلام إجراء صيغة الزواج عند وجود العادة الشهرية؛ إذ من الممكن أنّ الزوجين اللذين يلتقيان لأوّل مرّة لا يمتنعان عن بعضهما في وقت العادة، بخلاف الحال في الطلاق الذي هو انفصال وافتراق ولا تأثير للعادة فيه. ولكنّ الإسلام باعتباره يؤيّد (الوصل) ويعارض (الفصل)، جعل وقت العادة مانعاً من وقوع الطلاق، ولم يجعله مانعاً من صحّة الزواج. وفي بعض الحالات يجب (التربّص) ثلاثة أشهر من أجل أن يصبح إجراء الطلاق جائزاً وبديهي أنّ جميع هذه المعوّقات والموانع قد أوجدت على أمل أن تزول في خلال هذه المدة، المشاكل أو الغضب الذي كان قد أدّى إلى التصميم على الطلاق ويعود الزوجان إلى حياتهما الاعتيادية.
وعلاوة على ذلك، فحين تكون الكراهية من قِبل الرجل ويوقع الطلاق بشكل رجعي، تعطى للرجل فرصة للتفكير باسم (العدة) يمكنه خلالها أن يرجع إلى زوجته.
فالإسلام بفرضه نفقات الزواج والعدّة وحفظ ورعاية الأطفال على عاتق الرجل، يكون قد وضع عائقاً عملياً أمام الرجل للتخلّي عن الطلاق. فالرجل الذي يرد طلاق زوجته والزواج من أخرى، يجب أن يدفع نفقة عدّة الزوجة الأولى، ونفقات أولاده منها، ويدفع مهر الزوجة الجديدة، ويتعهّد بنفقاتها من جديد ونفقات أولادها القادمين.
هذه الأمور - علاوةً على مسؤولية ورعاية الأطفال الذين قد طُلّقت أُمّهم - تشكّل صورة مخيفة للرجل من الطلاق وتحول بينه وبين إيقاعه.
وبغضّ النظر عن كل ذلك، فإنّ الإسلام أوجب - عند وجود الخوف من انهيار المؤسّسة العائلية - تشكيل محكمة عائلية لتحكم في الخلاف بين الزوجين، يتم على أساسها تعيين حكم ينوب عن الزوج وحكم ينوب عن الزوجة من أجل الإصلاح.
هذان الحكمان يبذلان أقصى الجهود من أجل أن يصلحا بينهما ويحلاّ خلافاتهما وإذا وجدا أحياناً - وبعد التشاور مع الزوجين - أنّ الانفصال أصلح لهما فرّقا بينهما بالطلاق. وبالطبع إذا كان بين أهل الزوجين أفراد يصلحون للحكم بينهما كانوا أولى من غيرهم بتولّي الحكم. وينص القرآن الكريم في الآية 35 من سورة النساء على ذلك قائلاً:( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِن
يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنّ اللهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً ) .
يقول صاحب تفسير الكشّاف في تفسير كلمة (حكم): (أي رجلاً مقنعاً رضيّاً يصلح لحكومة العدل والإصلاح بينهما).
ثم يقول: إنّ السبب في أن يكون الحاكمان - بالدرجة الأولى - من بين أقارب الزوجين، هو أنّ الأقارب أكثر اطلاعاً من غيرهم على ما يجري بينهما، كما أنّ حرصهم على الإصلاح بين الزوجين أكثر من حرص الغريب. وعلاوة على هذا: الزوجين يمكن أن يكشفا من أسرارهما الخاصة للأقارب أكثر ممّا يكشفانها للغريب، وما يمكن أن يصرّحا به من الأسرار لأقاربهما قد لا يصرّحان به أمام الغير.
بقي أن نقول: هل إنّ تشكيل هذه المحكمة واجب أم مستحب؟ يوجد في هذا المجال اختلاف بين العلماء:
يقول المحقّقون إنّ ذلك من مهمّة الحاكم وهو واجب. ويفتي الشهيد الثاني في المسالك بصراحة بأنّ مسألة التحكيم بالترتيب الذي ذكر واجب وضروري وهو من مهام الحكّام.
والسيد محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار بعد أن يذكر رأيه في أنّ تشكيل المحكمة واجب، يشير إلى اختلاف علماء الإسلام حول وجوب أو استحباب هذا العمل ويقول: إنّ الذي يفتقد عملياً بين المسلمين هو هذا العمل والاستفادة من مزاياه التي لا تحصى، فالطلاق يقع باستمرار، والشقاق والخلاف يجد طريقة دائماً إلى البيوت والعوائل
بدون أن يستفاد ولو أقل فائدة من مبدأ التحكيم الذي نصّ عليه القرآن الكريم، بينما تصرف طاقة علماء الإسلام في النقاش والجدل حول وجوب أو استحباب هذا العمل. وليس هناك شخص يقول: سواء كان ذلك واجباً أم مستحباً، لماذا لا تخطون خطوة لتنفيذه؟ لماذا تصرفون كل جهودكم في الجدل والنقاش؟ فإذا لم يعمل به ولم يستفد الناس من مزاياه، فما الفرق بين أن يكون واجباً أو مستحبّاً؟
ويقول الشهيد الثاني، فيما يخص الشروط التي يمكن أن يفرضها الحكمان على الزوج للإصلاح بين الزوجين: (مثلاً يلزم الحكمان الزوج أن يسكن زوجته في البيت الفلاني أو المدينة الفلانية، أو مثلاً: ألاّ تسكن والدته أو امرأة أخرى في نفس بيت الزوجة ولو في غرفة منفصلة، أو أن يدفع نقداً مهر زوجته الذي في ذمّته مثلاً، أو - كان لزوجته دين في رقبته - أن يدفعه لها فوراً).
والغرض أنّ كل عمل يعيق إقدام الزوج على إنجاز الطلاق هو عمل سليم ومطلوب في نظر الإسلام.
وهنا نأتي للإجابة عن السؤال الذي طرح في المقالة الثانية والعشرين كما يلي: هل يحق للمجتمع (أي الهيئة التي اسمها المحكمة والتي تنوب عن المجتمع) أن تتدخّل في أمر الطلاق - الذي هو مبغوض ومكروه في نظر الإسلام - بالشكل الذي يعيق الرجل عن إيقاعه؟
الجواب: يمكن لها بالطبع أن تفعل ذلك؛ لأنّ التصميم على الطلاق
ليس في كل الحالات علامة على الموت الحقيقي للزواج، أي ليس كل حالات التصميم على الطلاق دالة على الانطفاء التام لشعلة حب الرجل وسقوط المرأة من مكانها الطبيعي، وعدم قابلية الرجل على الاحتفاظ بها؛ إذ إنّ أكثر الحالات تكون عادة إثر الغضب أو الغفلة أو الخطأ. فكل ما يقدم عليه المجتمع من إجراءات تعيق فيه الطلاق الناشئة عن الغضب والغفلة، أمر يرحّب به الإسلام.
ويمكن للمحاكم - باعتبارها نائبة عن المجتمع - أن تمنع مسؤولي مكاتب الطلاق من إيقاعه إلى أن تبلغهم هي بفشل جهودها في الإصلاح بين الزوجين، وخلال تلك الفترة تقوم ببذل المساعي الجدّية من أجل الإصلاح بين الزوجين، حتى إذا ثبت لها عدم إمكانية الصلح بينهما؛ أصدرت بياناً بهذا الخصوص لإطلاع مسؤول مثل هذه المكاتب.
2 - الخدمات السابقة التي أدّتها المرأة للأُسرة
إنّ طلاق الغدر علاوة على ما يسبّبه من انهيار المؤسسة العائلية المقدّسة، فإنّه يوجد مشاكل خاصة للمرأة لا يمكن التغاضي عنها، فالمرأة عاشت سنين طويلة تخلص لهذا الرجل، ولا ترى بينه وبينها فرقاً في الملكية، وترى البيت بيتها هي كما هو بيته، وقد بذلت أقصى الخدمات والجهود من أجل ترتيبه وتنظيمه، وفي الغالب أنّ النساء - غير النساء المتحضّرات من سكنة المدن - يجتهدن في التقشّف في
المأكل والملبس ونفقات المنزل إلى حدٍّ يغضب الرجال، ويتضايقن من فكرة استخدام خادمة للبيت من أجل توفير بعض النفقات، ويبذلن قصارى جهودهن وينفقن شبابهن وسلامتهن من أجل البيت أو في الواقع من أجل الزوج. والآن لنفرض أنّ زوج مثل هذه المرأة - بعد هذه السنين من العيش المشترك - يثور في رأسه هوى الزواج من امرأة جديدة وطلاق زوجته الأولى ثم الإتيان بالزوجة الثانية إلى بيت الأولى ومصادرته منها، هذا البيت الذي بنته بجهودها وأفنت من أجله زهرة شبابها وصحّتها وأصبح محط آلامها وآمالها تخسره في لحظة طيش وهوى زوجها الذي يريد أن يهوي بثمرة جهودها وتعبها. فما العمل في هذه الحال؟
هنا لم تعد المسألة انهيار الأُسرة وتفكّك عرى الرابطة الزوجية كي نقول: إنّ غدر الزوج يؤدّي إلى موت الزواج، وأنّ فرض الزوجة على هذا الزواج الغادر يقلّل من شأنها ومكانتها الطبيعية.
وهناك مسألة أخرى هي مسألة التشريد والحرمان من كل شيء، مسألة تسليم العش إلى المنافس، مسألة ضياع ثمرة الجهود والأتعاب والأنصاب والخدمات.
ليذهب الزوج والبيت والعائلة والحياة الزوجية المنطقية إلى جهنم، لكن كل إنسان يريد أن يكون له مأوى وبيت، وهو متعلّق بعشّه الذي بناه بيده؛ إذ لو أُريد إخراج حمامة من عشّها وبيتها الذي بنته، لدافعت
عنه. أفليس من حق المرأة أن تدافع عن بيتها وعشها؟ أو ليس هذا العمل ظلماً واضحاً من جانب الرجل؟ فما هو رأي الإسلام بهذا الخصوص؟
في نظرنا أنّ هذه المسألة جديرة جداً بالاهتمام، وأنّ أكثر المشاكل الناجمة عن الطلاقات الغادرة هي من هذا النوع. ففي مثل هذه الحالات لا يكون الطلاق مجرد فسخ عقد وحسب بل خسارة فادحة أشبه بإفلاس التاجر، وقضاء كامل على المرأة.
لكن، وكما أشرنا في متن السؤال، فإنّ مسألة البيت والعش منفصلة عن مسألة الطلاق، ويجب بحثهما كلاًّ على حدة. أمّا من وجهة نظر الإسلام والقوانين الإسلامية فهذه المشكلة قد حُلّت وما وقوعها إلاّ نتيجة الجهل بالقوانين الإسلامية واستغلال الرجال لوفاء النساء وطيبتهن.
وإنّ هذه المشكلة ناجمة عن اعتقاد أكثر الرجال والنساء بأنّ عمل المرأة وخدمتها في بيت الرجل ونتائج هذه الخدمة هي ملك للرجل، بل إنّهم يعتقدون أنّ للرجل الحق في أن يصدر الأوامر للمرأة كما لو كانت أُمّة مأجورة وعلى المرأة أن تطيع أوامره. هذا في الوقت الذي قد ذكرنا مراراً أنّ المرأة لها حرية كاملة في العمل والفعّالية، وإنّ ثمرات عملها ملك لها وليس للرجل حق في أن يتصرّف معها كرب عمل، إنّ الإسلام بفعل الاستقلال الاقتصادي الذي منحه للمرأة وبفعل وضعه النفقات
عنها وإلقائها على عاتق الرجل لتأمين احتياجاتها واحتياجات أولادها، قد منحها فرصة كافية وتامّة لكي تستغني عن الرجل وتصون كرامتها من الاحتياج إلى المال والثروة بحيث لا يكون هذا الجانب سبباً في قلقها فيما لو طلّقها زوجها، وأنّ جميع الأشياء التي وفّرتها هي لمنزلها وعشّها ملك لها وليس للرجل الحق في سلبها منها. وهذا النوع من القلق يرتبط بالنظم التي تكون فيها المرأة مرغمة على العمل في بيت الزوج، ويتملّك الزوج ثمرات عملها وجهودها. والقلق الموجود بين شعوبنا من هذه الناحية ناشئ - غالباً - عن الجهل بالقانون الإسلامي.
والسبب الآخر لهذه المشاكل هو استغلال الرجل لوفاء المرأة، فإنّ بعض النساء يضحّين من أجل بيوتهن، لا لجهلهن بقوانين الإسلام وإنّما لثقتهن بالأزواج. فهنّ يرغبن في ألاّ يكون بينهن وبين الأزواج مسألة أنا وأنت؛ ولهذا لا يفكّرن في مصلحتهن الخاصة، ولا في اغتنام الفرصة التي هيّأها الإسلام لهنّ، ويفتحن أعينهنّ ذات يوم ليجدن أنّ العمر قد انقضى بالتضحية من أجل شخص لا وفاء له ودون أن يستفدن من الفرص الكافية التي منحها الإسلام لهن.
إنّ أمثال هؤلاء النسوة يجب أن يدركن منذ البداية أنّ (ما أحسن أن يكون الحنان من الطرفين)(1) ، فإذا كانت المرأة تريد التخلّي عن حقّها الشرعي في تهيئة المال الخاص بها وبناء عش يكون ملكاً لها، وتريد أن
____________________
(1) ترجمة لمثل إيراني يقول: (چه خوش بي؛ مهرباني از دو سر بي).
تهب زوجها كل طاقاتها وجهودها، فعلى الزوج بالمقابل، وعملاً بقول الله تعالى:( وَإِذَا حُيّيتُم بِتَحِيّةٍ فَحَيّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدّوهَا ) أن يهب زوجته شيئاً يعادل ذلك أو يزيد عليه في القيمة بشكل هدية. ومن الأمور المتداولة بين الرجال الأوفياء أنّهم يهدون لزوجاتهم أشياء ثمينة أو بيتاً أو ملكاً آخر في مقابل تضحياتهن وخدماتهن الصادقة.
وعلى كل حال فمشكلة تشريد الزوجة لا علاقة لها بالطلاق، وتغيير قانون الطلاق لا يحل هذه المشكلة. إنّها ترتبط بالاستقلال الاقتصادي للمرأة أو عدمه، وقد وضع الإسلام حلاًّ لذلك. هذه المشكلة قد سادت في أوساطنا بسبب جهل بعض النساء بالتعاليم الإسلامية، وغفلة وبساطة البعض الآخر. فلو أنّ النساء وعين قيمة الفرصة التي هيّأها الإسلام لهنّ في هذا المجال، ولم تكن تضحيتهن وتسامحهن في سبيل الزوج عن سذاجة؛ لحلّت هذه المشكلة نفسها بنفسها.
(5) حق الطلاق
يتذكّر القارئ الكريم أنّنا ذكرنا في المقال الثاني والعشرين أنّ مشاكل الزواج عندنا تتلخّص في جانبين:
الأول: الطلاق الغادر وينشأ عن عدم الوفاء وانعدام الروح الإنسانية لدى بعض الرجال.
الثاني: الامتناع الغادر من قِبل بعض الرجال عن طلاق المرأة التي
لا أمل في التوفيق بينها وبين زوجها، فهو يمتنع عن الطلاق لا رغبةً في العيش معها وإنّما في تعذيبها. وقد بحثنا الجانب الأول في الفصلين السابقين، وقلنا إنّ الإسلام يرحّب بكل ما يؤدّي إلى منع الطلاق الغادر، كما سعى - بتدابير خاصة وضعها - إلى الحيلولة دون وقوع مثل هذا الطلاق. لكنّه عارض استعمال القوّة في أحكام الروابط العائلية.
يتبيّن - ممّا قيل لحد الآن - إنّ العائلة في نظر الإسلام كائن حي، والإسلام يسعى من أجل أن يبقى هذا الكائن حيّاً، وينظر إليه بأسى وحزن حين يموت ويأذن بدفنه، لكنّه غير مستعد لتحنيطه بحنوط القانون ولا الاحتفاظ به محنّطاً على هذه الصورة.
وتبيّن أنّ سبب منح الرجل حق الطلاق هو أنّ العلاقة الزوجية القائمة على أساس طبيعي ولها تركيبة خاصة وحركة خاصة، وقد سلّمت الطبيعة مفتاح توثيق هذه العلاقة ومفتاح إضعافها والقضاء عليها بيد الرجل أيضاً. وكل من المرأة والرجل له موقع خاص بالنسبة لصاحبه بحكم الطبيعة، وهذا الموقع غير قابل للتغيير ولا للتماثل، وقد أسفر هذا الموقع والوضع بدوره عن نتائج عديدة ومن جملتها حق الطلاق. وبتعبير آخر: إنّ سبب هذا الأمر هو الدور الخاص والمتميّز لكل من المرأة والرجل في مسألة الحب والبحث عن الزوج لا شيء آخر.
حق الطلاق نابع من دور الرجل الخاص في مسألة الحب لا من ملكيّته
وهنا يمكنكم أن تتبيّنوا قيمة الدعايات التي يطلقها أعداء الإسلام، فهم تارة يقولون إنّ السبب الذي دعا الإسلام إلى منحه الرجل حق الطلاق هو أنّه لا يرى المرأة ذات إرادة ومشاعر وآمال، بل يعتبرها من جملة الأثاث لا الأشخاص. إنّ الإسلام يعتبر الرجل مالكاً للمرأة ويمنحه بحكم (الناس مسلّطون على أموالهم ) الحق في أن يعتق في أي وقت يشاء.
ولكن قد تبيّن أن منطق الإسلام ليس مبنيّاً على أنّ الرجل مالك والمرأة مملوكة، وتبيّن أنّ منطق الإسلام أدق وأرقى من مستوى أفكار هؤلاء الكتّاب. إنّه - بنور الوحي - قد أدرك نقاطاً وأسراراً في أساس بناء الأُسرة لم يقترب العلم من معرفتها إلاّ بعد أربعة عشر قرناً.
الطلاق تفريق، بينما الزواج تأليف
وتارة يقولون: لماذا يتخذ الطلاق صورة التسريح؟ وأنّه يجب أن يتخذ شكلاً قضائياً؟. وجوابنا لهؤلاء: إنّ الطلاق تسريح من حيث يكون الزواج صحبة، فإنّكم استطعتم أن تغيّروا قانون البحث عن الزواج في مطلق جنس الذكر والأُنثى وأخرجتم الصورة الطبيعية عن شكل الصحبة، وإذا استطعتم - في علاقات جنس الذكر بجنس الأنثى في الحيوانات والإنسان - أن تجعلوا لكل منهما دوراً مشابهاً لدور الآخر،
وغيرتم قانون الطبيعة عندها فقط يمكنكم أن تخرجوا الطلاق عن صورة التسريح.
ويكتب أحد هؤلاء قائلاً: (إنّ عموم فقهاء الشيعة يعتبرون عقد الزواج من العقود الملزمة، كما أنّ القانون المدني الإيراني يعتبره - حسب الظاهر - كذلك، لكنّني أريد أن أقول إنّ عقد النكاح طبقاً للفقه الإسلامي والقانون المدني الإيراني ملزم للمرأة فقط، أمّا للرجل فعقد جائز، إذ إنّه متى ما أراد أن يلغي أثر هذا العقد؛ أنهى الزواج).
ثم يقول: (إنّ عقد الزواج جائز للرجل وملزم للمرأة، وهو ظلم قانوني؛ لأنّه جعل المرأة أسيرة الرجل. إنّني كلّما قرأت المادة 1132 من القانون المدني لدولة إيران الشاهنشاهية (قانون حق الرجل في الطلاق)، أشعر بالخجل من سيّدات إيران، ومن هذه المدارس والجامعات، ومن هذا القرن الذرّي والأقمار والديمقراطية).
إنّ هؤلاء السادة - ابتداءً - لم يتمكّنوا من إدراك أمر واضح هو أنّ الطلاق غير فسخ عقد الزواج، أمّا قولهم إنّ عقد الزواج ملزم بالطبع، فهذا يعني أن ليس لأي من الزوجين (إلاّ في حالات خاصة) الحق في فسخه. فإذا فسخ العقد، بطلت كل الأمور التي تترتّب عليه وكأنّ شيئاً لم يكن، ومن جملتها المهر، وعندها ليس للمرأة حق المطالبة به، ولا بنفقة العدّة، بخلاف الطلاق الذي ينهي العلاقة الزوجية لكنّه لا يمحو آثار العقد تماماً، فلو أنّ رجلاً عقد زواجه على امرأة وجعل مهرها مثلاً
خمسمئة ألف تومان ثم أراد بعد يوم واحد من الحياة الزوجية المشتركة أن يطلّقها بعد العقد وقبل الارتباط الزوجي (الدخول) وجب عليه أن يدفع نصف المهر. ولما كانت المرأة في هذه الحالة لا عدة لها، فقد انتفى موضوع نفقة العدّة. يتبيّن من هذا أنّ الطلاق يمكنه إزالة كل آثار العقد، بينما لو أنّ عقد الزواج المذكور قد فُسخ، لما كان للمرأة حق في المهر. ومن هنا يفهم أنّ الطلاق غير الفسخ. فحق الطلاق لا يتنافى مع إلزامية العقد. والإسلام إنّما ينظر إلى أمرين: أمر الفسخ وأمر الطلاق. أمّا حق الفسخ فقد أُعطي للمرأة والرجل على حدٍّ سواء عندما تكتشف عند أحدهما عيوب معيّنة فيحق للآخر أن يفسخ بخلاف حق الطلاق الذي حصر بالرجل في حالة فقدان روح الحياة العائلية.
فكون الإسلام قد عامل الطلاق بغير ما عامل الفسخ، ووضع تعاليم ومقرّرات خاصة للطلاق فذلك يعني أنّه في منطق الإسلام لم يعط حق الطلاق للرجل بهدف منحه ميزة خاصة.
يجب أن يقال لمثل هؤلاء المعترضين إنّه من أجل ألاّ تخجلوا من المدارس والجامعات والأقمار الصناعية ادرسوا لمدّة من الزمان؛ كي تفرّقوا بين الفسخ والطلاق وتتعرّفوا على الفلسفة الإسلامية العميقة والدقيقة للمجتمع والأُسرة، لكي لا تخجلوا من المدارس والجامعات وحسب، بل لتمرّوا من أمامهم مرفوعي الرؤوس. لكنّ المؤسف هو أنّ الجهل مرض صعب الشفاء.
العقوبة المترتّبة على الطلاق
وضعت في بعض قوانين العالم القديم غرامة معيّنة من أجل منع الطلاق، ولا أعلم ما إذا كانت في قوانين العالم اليوم مثل هذه الغرامة أم لا. لكن قرأت أنّ أباطرة روما المسيحية كانوا يعاقبون الزوج الذي يطلّق زوجته بدون سبب وجيه. بديهي أنّ هذا نوع آخر من أنواع استخدام القوّة من أجل تثبيت بناء الأُسرة ولكن لا فائدة ترتجى منه.
منح المرأة حق الطلاق كحق تفويضي
هنا يجب أن نوضح أمراً، هو أنّ جميع أحاديثنا كانت على أساس أنّ الطلاق حق طبيعي خاص بالرجل، أمّا كون الرجل يستطيع أن يعطي حق الطلاق للمرأة - وكالة عنه - بشكل مطلق، أو في حالات معيّنة، فمسألة أخرى يقبلها الفقه الإسلامي ويصرّح بها القانون المدني الإيراني. ومن أجل ألاّ يتراجع الرجل من هذا التوكيل فيسلب المرأة حقّها التفويضي، أي من أجل أن تكون الوكالة مضمونة وسارية المفعول حتى النهاية، يذكر هذا التوكيل كشرط ضمن العقد، وبموجب هذا الشرط يمكن للمرأة أن تطلّق نفسها مطلقاً أو في حالات خاصة تعيّن منذ البداية.
ولهذا، فمنذ قديم الزمان تقوم النساء - اللواتي يعوزهن الاطمئنان الكامل إلى أزواج المستقبل - بالاحتفاظ لأنفسهن بحق الطلاق بصورة شرط ضمن العقد ليستفدن منه عند الضرورة.
ففي نظر الفقه الإسلامي، لا تملك المرأة حق الطلاق بصورة طبيعية، لكن يمكنها ذلك بصورة وضعية، أي باشتراطه ضمن العقد.
جاء في المادة (1119) من القانون المدني ما يلي: (يحق لطرفي عقد الزواج أن يشترطا أي شرط لا يتعارض ومقتضيات العقد المذكور؛ وذلك ضمن عقد الزواج أو أي عقد ملزم آخر، كما لو اشترط مثلاً أنّه لو تزوّج الزوج من امرأة ثانية أو غاب لمدّة معيّنة أو توقّف عن الإنفاق آو حاول الإساءة إلى حياة الزوجة أو أساء الأخلاق معها، بحيث أصبحت حياتهما المشتركة مستحيلة، فإنّ الزوجة تستطيع - بناءً على توكيل زوجها لها - أن تطلّق نفسها بعد إثبات تحقّق الشرط في المحكمة وصدور حكم نهائي بذلك).
وكما تلاحظون، فإنّ ما يقولونه - من أن الطلاق حق من جانب واحد... أُعطي للرجل فقط وسلب من المرأة كليّاً، - أمر غير صحيح في نظر الفقه الإسلامي والقانوني المدني الإيراني.
في الفقه الإسلامي وكذلك القانون المدني الإيراني لا وجود لحق الطلاق للمرأة بشكل حق طبيعي، بل يمكن أن يوجد بشكل حق وضعي.
والآن يأتي دور القسم الثاني من بحثنا، أي موضوع الامتناع الغادر والظالم من بعض الرجال عن إيقاع الطلاق. لننظر هل وضع الإسلام حلاًّ لهذه المشكلة التي هي في حقيقتها مشكلة كبرى أم لا؟ هذا
ما سنبحثه في الفصل القادم تحت عنوان (الطلاق القضائي).
الطلاق القضائي
الطلاق القضائي هو الطلاق الذي يجريه القاضي لا الزوج.
في كثير من قوانين العالم، وضع الطلاق كليّاً بيد القاضي، والمحكمة هي وحدها التي يحق لها إبداء الرأي في الطلاق وإنهاء الزوجية، وجميع حالات الطلاق - في نظر هذه القوانين - هي من نوع الطلاق القضائي. وقد أوضحنا في المقالات السابقة بطلان هذه النظرية على أساس تفهّم روح الزواج، والهدف من تشكيل المؤسسة الأُسرية، والموقع الذي يجب أن يكون للمرأة في محيط الأُسرة، وأثبتنا أنّ حالات الطلاق التي تقع بصورة عادية لا يمكن أن تخضع لوجهة نظر القاضي.
أمّا بحثنا الحالي فيدور حول، هل للقاضي في نظر الإسلام - مع كل الشروط القاسية التي يشترطها الإسلام في القاضي - حق الطلاق مهما كانت الظروف والأوضاع، أم أنّ له الحق في حالات خاصة على قلّتها وندرتها؟
إنّ الطلاق هو الحق الطبيعي للرجل، ولكن بشرط أن تكون علاقته بالمرأة طبيعية، ومعيار طبيعية هذه العلاقة هو أنّه إذا أراد الحياة المشتركة مع المرأة فيجب عليه أن يعاشرها بالحسنى والمعروف، وذلك بأن لا يمتنع عن طلاقها، بل يدفع لها حقوقها الواجبة ومبلغاً إضافياً تنفيذاً لقوله تعالى:
( وَمَتّعُوهُنّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) (1) .
ويعلن انتهاء العلاقة الزوجية.
أمّا إذا لم تجر الأمور بصورتها، فما العمل؟ إي حين يوجد رجل لا هو يريد العيش المشترك فيحسن معاشرة الزوجة ويبني أُسرة سعيدة كما يريد الإسلام، ولا هو يطلّقها لتذهب إلى حال سبيلها، وبتعبير آخر: لا هو يقوم بواجبات الزوجية فيرضي زوجته ولا هو يرضى أن يطلقها. فما العمل في هذه الحالة؟
إنّ الطلاق الطبيعي كالولادة الطبيعية يطوي مراحله بصورة طبيعية، أمّا طلاق الرجل الذي لا يقوم بواجباته الزوجية ولا يرضى أن يطلّق، فشبيه بالولادة غير الطبيعية، حيث لابدّ من تدخّل الطبيب والجرّاح لإخراج الطفل.
هل أنّ بعض الزيجات
سرطان وأنّ المرأة يجب أن تشقى لتبقى؟
والآن لننظر ماذا يقول الإسلام عن مثل هذا الطلاق ومثل هؤلاء الرجال؟ هل يقول أيضاً إنّ الطلاق يرتبط برأي الرجل مئة بالمئة، فإذا لم يوافق مثل هذا الرجل على الطلاق، فيجب على المرأة أن تشقى لتبقى، بينما يقف الإسلام موقف المتفرّج؟
____________________
(1) سورة البقرة، الآية 236.
إنّ رأي الكثيرين هو: (أنّ هذا الأمر لا يقبل العلاج في نظر الإسلام، إنّه نوع من السرطان الذي يصيب بعض الناس أحياناً ولا يملكون له علاجاً، ويجب على المرأة أن تشقى لتبقى... حتى تنطفئ شمعة حياتها بالتدريج).
وفي نظري، إنّ هذا النوع من التفكير يتعارض مع المبادئ الإسلامية المعروفة، فالدين الذي ينادي بالعدل، ويعتبر (القيام بالقسط ) هو الهدف المبدئي والأساس لجميع الأنبياء:( لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ ) (1) .
كيف يمكن أن لا يفكّر في حلّ لمثل هذا الظلم الفاحش الواضح؟ وهل يمكن أن يضع قوانينه بالشكل الذي تنجم عنه معاناة الضعفاء لما يشبه السرطان ويتجرّعوا الغصص والآلام حتى الموت؟
إنّ ممّا يدعو إلى الأسف أن يعتقد بعض الأفراد - الذين يقرّون بأنّ الإسلام دين العدل وهم أنفسهم أعضاء محاكم - بمثل هذا الرأي، ولو أنّنا ألصقنا بالإسلام قانوناً ظالماً تحت عنوان (السرطان)، فلن نجد بأساً بعد ذلك من قبول قانون ظالم آخر تحت عنوان (الكزاز)، وآخر بعنوان (السل)، ورابع عنوان (الشلل)، ومجموعة أخرى من القوانين الظالمة
____________________
(1) سورة الحديد، الآية 25.
بعناوين أخرى.
إذا كان الأمر كذلك، فأين مبدأ العدل الذي هو أساس التقنين الإسلامي؟ وأين (القيام بالقسط ) الذي هو هدف الأنبياء؟
إنّهم يقولون: سرطان. وأقول: حسناً، إذا كان سرطاناً ويمكن إنقاذ المصاب به بعملية جراحية، أفلا يجب أن تجرى له العملية فوراً لإنقاذه؟
فالمرأة التي تتزوّج من رجل لتشاركه حياته، ثم تتغيّر الأمور إلى وضع يسئ فيه الرجل استخدام صلاحياته، ويمتنع عن طلاق المرأة لا من أجل أن تبقى له زوجة وشريكة في الحياة وإنّما ليحول بينها وبين الزواج مجدّداً ممّن يناسبها وينسجم معها، وبتعبير القرآن يذرها( كَالْمُعَلَّقَةِ ) ، هذه المرأة قد ابتُليت حقّاً بما يشبه السرطان. لكنّ هذا السرطان هو من النوع الذي يمكن استئصاله بالعملية الجراحية ويشفى المصاب به شفاءً كاملاً، مثل هذا العلاج وهذه العملية يمكن قبولها إذا تمّت على أيدي حكّام أو قضاة شرعيين جامعين للشرائط الإسلامية المعتبرة.
كما ذكرنا في المقالات السابقة: أنّ إحدى المشكلتين الكبيرتين في مجتمعنا في باب الطلاق هي امتناع بعض الرجال الظالمين عن إيقاع الطلاق، وهم بذلك يرتكبون ظلماً كبيراً باسم الدين. هذا النوع من الظلم، إضافة إلى ذلك النوع من التفكير الخاطئ الذي يقول: إنّ المرأة يجب أن تتحمّل هذا اللون من الظلم على أنّه سرطان غير قابل للعلاج،
كان مدار تشهير وتنديد بالإسلام؛ ترك أثراً سيئاً لم يتركه غيره من الشبهات.
وبالرغم من أنّ البحث في هذا الموضوع يقودنا إلى جوانب فنّيّة وتخصّصية، ويخرجنا عن حدود هذه المقالات إلاّ أنّني أرى أنّه يجب البحث فيه ولو إلى الحد الذي يرفع الغشاوة عن أعين المتشائمين؛ ليروا أنّ ما يقوله الإسلام هو غير ما يقوله هؤلاء الناس.
طرق مسدودة
إنّ مثل هذه المغالق لا تقتصر على قضايا الزواج والطلاق فحسب، فهي ترد أيضاً في مسائل أخرى كالأمور المالية، فلننظر أوّلاً ماذا فعل الإسلام تجاه مثل هذه الحالات في غير مجالات الزواج والطلاق. فهل تعامل معها على أنّها طريق مسدودة وظاهرة غير قابلة للحل، أم أنّه فتح الطريق وحل إشكالها؟
فلنفرض أنّ شخصين ورثا معاً شيئاً لا يقبل التقسيم كالجوهرة أو الخاتم أو السيّارة أو لوحة فنّيّة، وهما يرفضان استعماله على سبيل التناوب كأن يكون مرّة عند أحدهما ومرّة عند الآخر، كما يرفض كل منهما بيع حصّته إلى الآخر، ويرفضان كل أنواع الحلول الأخرى. فمن ناحية نعلم أنّ تصرّف أيّ منهما بهذا الإرث يتوقّف على إذن ورضا الطرف الآخر فما العمل في هذه الحالة؟ هل يبقى هذا الشيء معطّلاً لا يستفيد منه أحد، ويعتبر الموضوع أمراً غير قابل للحل؟ أم أنّ
الإسلام قد وضع لمثل هذه الحالات حلاًّ مناسباً؟
الحقيقة هي أنّ الفقه الإسلامي لا ينظر إلى مثل هذه المسائل على أنّها أمر مستعصٍ على الحل. فهو لا يعترف بحق الملكية الذي يقول إلى ترك المال مجمّداً لا يستفيد منه أحد. فيمنح في مثل هذا الحالات - لمنع بقاء الثروة مجمّدة - صلاحية لحاكم الشرع باعتبار أنّ المسألة تتعلّق بأمر اجتماعي، أو للقاضي باعتبار مسألة خلافية، لوضع حلّ لها بالرغم من امتناع أصحاب الحق الشرعيين عن قبول الحل. فمثلاً يؤجّر ذلك المال ويسلّم قيمة الإجارة إلى الطرفين بالتساوي، أو يبيعه ويقسّم ثمنه بينهما بالتساوي. وعلى كل حال، فإنّ من واجب الحاكم أو القاضي باعتباره (ولي الممتنع) أن يحل هذه المشكلة سواء رضي أصحاب المال الأصليين بذلك أم لم يرضوا.
والآن نتساءل: لماذا لم يراع حق الملكية في مثل هذه الحالات؟ الجواب: إنّ هناك مبدأ آخر يجري تطبيقه هنا، هو مبدأ الحيلولة دون هدر المال وتعطيله. فإنّ مراعاة حق الملكية لأصحاب المال تكون في حدود عدم تعطيل المال وتركه بدون أن يستفيد منه أحد. فلو فرضنا أنّ الشيء المختلف عليه جوهرة أو سيف أو شيء آخر من هذا القبيل، وكل من الطرفين لا يرضى أن يبيع للآخر، لكنّهما مستعدّان لتقسيمه نصفين يكون لكل منهما نصف، أي إنّ العناد قد بلغ بهما إلى أن يتلفا هذه العين ويحرم الطرفان من الإفادة منها، إذ من البديهي أنّ الجوهرة أو
السيف أو السيّارة إذا قسمت نصفين تغدو غير قابلة للاستعمال. فهل يجيز الإسلام ذلك؟ كلاّ. لماذا؟ لأنّه إضاعة للمال.
يقول العلاّمة الحلّي (من أكابر فقهاء الدرجة الأُولى في الإسلام): إذا أرادا أن يفعلا ذلك، فلابد من منعهما، فإنّ موافقة صاحبي المال لا تكفي من أجل الإضرار به).
الطريق المسدود للطلاق
والآن لننظر ما الذي يجب عمله في قضية الطلاق؟ فإذا كان رجل معاند لا يقوم بأداء الواجبات التي وضعها الإسلام على عاتقه والتي بعضها مالي (النفقات) وبعضها أخلاقي (حسن المعاشرة) وبعضها يتعلّق بأمور الجنس (حق الصلة الجنسية)، وكان إهماله لها كلاّ أو بعضاً، كما أنّه في الوقت ذاته يرفض أن يطلق زوجته، فما العمل هنا؟ وهل يوجد في الإسلام مبدأ يمنع الحاكم أو القاضي الحق في التدخّل في هذه الحال، كما أجاز لهما ذلك بخصوص القضايا المالية أم ليس هناك هذا المبدأ؟
رأي آية الله الحلّي
وهنا أترك زمام الحديث لواحد من فقهاء الدرجة الأُولى في العصر الحديث وهو آية الله الحلّي المقيم في النجف الأشرف، فقد ذكر هذا الأمر في رسالة له باسم (حقوق الزوجية) وأبدى رأيه فيه:
وملخّص ما أورده حول ما يتعلّق بحقوق المرأة وامتناع الرجل ما يلي:
(الزواج عهد مقدّس، وهو في نفس الوقت نوع من المشاركة بين إنسانين تفرض على الطرفين مجموعة من الالتزامات، لا تؤمن سعادتهما إلاّ بالوفاء بها. كما سعادة المجتمع ترتبط كذلك بسعادة هذين، والوفاء بتعهّداتهما تجاه بعضهما.
والحقوق الأساسية للزوجة عبارة عن النفقة والكسوة، وحق الصلة الجنسية وحسن المعاشرة الأخلاقية.
فإذا تنصّل رجل عن القيام بواجباته تجاه زوجته، وامتنع في الوقت ذاته عن الطلاق، فما هو الحل؟ وكيف يجب التعامل مع هذا الرجل؟
وهنا نفترض حلّين: الأول أنّ للحاكم الشرعي حق التدخّل وحل المسألة بإيقاع الطلاق، والثاني أن تتنصّل المرأة أيضاً عن القيام بتعهّداتها تجاه الرجل.
أمّا الحل الأول أي تدخّل الحاكم الشرعي، فلننظر متى وفي أي الحالات يمكن للحاكم أن يتدخّل في هذا الأمر.
( الطّلاَقُ مَرّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ... ) (1) .
ومن ثمّ يعود ليقول في نفس السورة:
( وَإِذَا طَلّقْتُمُ النّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنّ فَأَمْسِكُوهُنّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرّحُوهُنّ
____________________
(1) البقرة: 229.
بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) (1) .
ويفهم من هذه الآيات مبدأ عام هو أنّ الرجل في الحياة الزوجية لابدّ أن يختار أحد طريقين، فإمّا أن يقوم بواجباته كما يليق( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ) وإمّا أن يقطع الصلة الزوجية ويخلّي سبيل المرأة( تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) أمّا الخيار الثالث، أي أن لا يطلّق المرأة ولا يتصرّف معها بالحسنى، فهذا ممّا لا يقرّه الإسلام. وجملة( وَلاَ تُمْسِكُوهُنّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا ) إنّما تنفي القسم الثالث من المعاملة. ولا يبعد أن تعني هذه الجملة مفهوماً شاملاً يتعلّق بالحالات التي يتعمّد فيها الرجل إيذاء المرأة، كما تشمل الحالات التي يتعمّد فيها الزوج إلحاق أذى بالزوجة إلاّ أنّ احتفاظه بها لا يجلب لها سوى الأذى والضرر.
هذه الآيات بالرغم من أنّها جاءت من أجل أن توضح تكليف الرجل لدى العدّة ورجوعه عن الطلاق أو عدم رجوعه، وتبيّن أنّ رجوع الرجل عن الطلاق يجب أن يكون على أساس الاحتفاظ بالمرأة كما يليق بها لا بقصد إيذائها. إلاّ أنّها ليست خاصة بهذه الحالة فحسب، بل هي مبدأ عام يبيّن الحقوق الزوجية في كل وقت وفي جميع الأحوال. وعلى هذا فالزوج بصورة عامّة يجب أن يختار أحد طريقين لا ثالث لهما.
____________________
(1) البقرة: 231.
وقد تصوّر بعض الفقهاء خطأً أنّ هذه الآيات خاصة بالرجال الذين يريدون الرجوع في العدّة، بينما توضّح هذه الآيات تكليف الرجال تجاه زوجاتهم في جميع الحالات، ودليلنا على ذلك - ما عدا سياق الآيات - أنّ الأئمّة الأطهار (عليهم السلام) قد استدلّوا واستشهدوا بها في غير مسألة العدّة:
فمثلاً قول الإمام الباقر (عليه السلام) حول حكم الإيلاء (أي حين يقسم الرجل ألاّ يقارب زوجته) إنّ الزوج يجب أن يخالف قسمه بعد أربعة أشهر ويدفع الكفّارة أو يطلّق الزوجة؛ إذ إنّ الله تعالى يقول:( إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) .
وكذلك حين سُئل الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل الذي كان قد وكّل آخر يعقد امرأة له وتعيين مهر لها عنه، فلمّا فعل الوكيل ذلك، أنكر الموكل الوكالة. أجاب ألاّ مانع من أن تتزوّج المرأة من آخر. وأمّا إذا كان الرجل الأول قد وكّل حقيقة وأنّ العقد كان صحيحاً بناءً على صحّة الوكالة فيجب عليه فيما بينه وبين الله أن يطلّق، ولا يترك المرأة بلا طلاق، واستشهد الصادق (عليه السلام) بالآية:( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) .
فيتبيّن من ذلك أنّ الأئمّة الأطهار (عليهم السلام) يعتبرون مفاد هذه الآية مبدأً عامّاً غير خاص بحالة واحدة.
إنّ الحاكم الشرعي يجب أن يأمر بإحضار الزوج الذي لا يقوم
بواجباته الزوجية ولا يطلّق. فيأمره أوّلاً بالطلاق، فإذا لم يطلّق، أوقع الحاكم الطلاق. يذكر أبو بصير رواية عن الصادق (عليه السلام) مفادها أنّ كل مَن كانت له امرأة لا يكسوها ولا ينفق عليها، فعلى إمام المسلمين أن يفرّق بينهما (أي بالطلاق)...)
كانت هذه خلاصة بسيطة لرأي فقيه من الدرجة الأولى في العصر الحاضر، ومَن أراد الاطلاع على تفاصيل أخرى فليراجع رسالة (حقوق الزوجية) من تقرير درسه.
وقد لاحظتم أنّ عبارة( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسـْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) هي مبدأ وقاعدة عامّة قرّر القرآن في إطارها حقوق الزوجية. والإسلام بالاستناد إلى هذا المبدأ - وخصوصاً التأكيد الوارد في عبارة( وَلاَ تُمْسِكُوهُنّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا ) - لا يجيز لرجل يعرف الله أن يسيء استخدام صلاحيّاته فيحتفظ بزوجة لا من أجل العيش معها بل من أجل مضايقتها ومنعها من الزواج من غيره.
شواهد وأدلّة أخرى
بالإضافة إلى ما ذكر من الشواهد والأدلة في رسالة حقوق الزوجية، هناك شواهد أخرى كثيرة تظهر أنّ عبارة( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) في نظر الإسلام مبدأ عام، وأنّ حقوق الزوجية يجب أن تراعى من خلال هذا الإطار. وكلّما توسّع القارئ في الاطلاع على هذه المسألة؛ اتضحت له سلامة ومتانة الأحكام الإسلامية.
روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) ما يلي:(1) (إذا أراد الرجل أن يتزوّج المرأة فليقل: (أقررت بالميثاق الذي أخذه الله: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).
وجاء في الآية 21 من سورة النساء:( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِيثَاقاً غَلِيظاً ) .
يقرّ مفسّرو الشيعة والسنّة على السواء أنّ المقصود بالميثاق الغليظ هو الميثاق الذي يأخذه الله على الرجل بقوله: (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) وهو نفس الميثاق الذي يشير إليه الإمام الصادق (عليه السلام) بقوله: (إذا أراد الرجل أن يتزوّج المرأة فليقل: (أقررت بالميثاق الذي أخذه الله: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)).
وقد نقل الشيعة والسنّة كلاهما جملة معروفة عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قالها في حجّة الوداع هي: (اتقوا الله في النساء فإنّكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله).
يقول ابن الأثير في كتاب النهاية: إنّ كلمة الله المقصودة بكلام النبي الأكرم (صلّى الله عليه وآله) التي استحلّ الرجال بها فروج النساء هي مفاد العبارة التي جاءت في القرآن (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).
____________________
(1) كتاب الكافي، ج5، ص502.
رأي شيخ الطائفة
يتحدّث الشيخ الطوسي في كتاب (الخلاف) الجزء الثاني صفحة 185 بشأن العنّين فيقول: (بعد أن يثبت أن الرجل (عنّين) فللمرأة خيار الفسخ) بعدها يقول: إنّ إجماع الفقهاء على هذا. ثم يقول مستدلاً بهذه الآية( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) و(لما كان العنين عاجزاً عن إمساك المرأة بمعروف فيجب عيه إذاً أن يسرّحها).
من مجموع ما مرّ يفهم بوضوح وبشكل قاطع أنّ الإسلام لا يمكن أن يجيز لرجل ظالم أنّ يسيء استخدام حق الطلاق ويحتفظ بالمرأة كسجينة. ولكن يجب ألاّ يفهم ممّا مرّ أنّ لكل مَن يحمل اسم قاض الحقّ في التدخّل في مثل هذه الأمور. فإنّ للقاضي في نظر الإسلام شروطاً ثقيلة ليس هنا مجال لشرحها. وأمر آخر يجب الإشارة إليه هو أنّ الطلاق القضائي في نظر الإسلام - بسبب اهتمام الإسلام بالإبقاء على المؤسسة العائلية - نادر الوقوع ولا يحصل إلاّ استثناءً. فهو لا يجيز أبداً أن يصبح أمر الطلاق كحاله في أمريكا وأوروبا ممّا نقرأ نماذج له دائماً في الصحف. مثلاً: إنّ امرأة شكت زوجها وطلبت الطلاق قائلة إنّه لا يحب الفيلم الذي أحبّه، أو إنّه لا يقبّل كلبي العزيز فيفي، وأمثال هذه المهازل التي تنمّ عن الانحطاط الإنساني.
* * *
أدرك القارئ المحترم ممّا ذكرنا في المقالات السابقة المفهوم
الذي سبق أن ذكر في المقالة الحادية والعشرين حيث كنّا قد أشرنا إلى خمس نظريات حول الطلاق على الترتيب التالي:
1 - عدم الاهتمام بالطلاق ورفع جميع القيود الأخلاقية والاجتماعية التي تحول دون وقوعه.
2 - أبديّة الزواج ومنع الطلاق بصورة عامة (نظرية الكنيسة الكاثوليكية).
3 - الزواج يقبل الإلغاء من قِبل الرجل ولا يقبل ذلك من قِبل المرأة مهما كلّف الأمر.
4 - يمكن إلغاء الزواج سواء كان بيد المرأة أو بيد الرجل طبقاً لشروط خاصة، وسبيل المرأة في ذلك نفس سبيل الرجل ومساوٍ له (نظرية المنادين بحق المساواة).
5 - طريق الطلاق كما هو مفتوح أمام الرجل فإنّه ليس مغلقاً بوجه المرأة، لكنّ باب خروج الرجل هو غير باب خروج المرأة.
وذكرنا في تلك المقالة أنّ الإسلام يتبنّى النظرية الخامسة، وقلنا عند الإشارة إلى مسألة الشرط المتضمّن في العقد ومسألة الطلاق القضائي، إنّه قد اتضح أنّ الإسلام مع أنّه لم يجعل الطلاق حقّاً طبيعياً للمرأة، إلاّ أنّه لم يغلق الطريق أمامها كليّاً، بل فتح لها أبواباً خاصة للخروج. وفيما يتعلّق بالطلاق القضائي، كان يمكن أن نبحث أكثر من ذلك خصوصاً إذا أخذنا بنظر الاعتبار آراء أئمّة وفقهاء سائر المذاهب
الإسلامية والتطبيقات العملية لذلك في مختلف البلدان الإسلامية، إلاّ أنّنا نكتفي في هذه المقالات بهذا القدر.
الفصل الحادي عشر
تعدّد الزوجات
1 - تعدّد الزوجات
نظام الزوجة الواحدة أقرب أنظمة الزواج إلى الطبيعة الإنسانية. في هذا النظام، تكون الملكيّة الفردية والخاصة - وهي غير ملكيّة الثروة طبعاً - هي الحاكمة. في هذا النظام يرى كل مَن الزوجين المشاعر والعواطف والتوجّه الجنسي لدى صاحبه ملكاً خاصاً به ولا حقّ لغيره فيه.
ويقابل هذا النظام، نظام تعدّد الزوجات أو الزواج الاشتراكي، ويمكن تقسيم هذا النظام إلى عدّة أنواع هي:
الشيوعيّة الجنسيّة
في هذا النوع لا يختص أحد بأحد إطلاقاً، أي لا تختص امرأة برجل معيّن ولا رجل بامرأة معيّنة؛ ولذا أُطلق عليه اسم الشيوعية الجنسية. وهي تعني محو الحياة العائلية. ولم يرو لنا التاريخ (ولا حتى النظريات التي تتناول مرحلة ما قبل التاريخ) خبراً عن مرحلة عاشها البشر انعدمت فيها الحياة العائلية وسادت فيها الشيوعية الجنسية. إنّ ما أطلقوا عليه الشيوعية الجنسية وادعوا وجوده عند بعض الشعوب
البدائية المتوحّشة، لم يكن إلا مرحلة وسطاً بين الحياة العائلية والشيوعية الجنسية. يقال إنّه كان يحصل عند بعض القبائل أن يتزوّج عدد من الإخوة بشكل مشترك من عدد من الأخوات، أو أن تتزوّج - بصورة مشتركة - مجموعة من رجال إحدى الطوائف من مجموعة من نساء طائفة أخرى.
يقول ويل ديورانت في الجزء الأول من تاريخ التمدّن صفحة 60 ما ترجمته: (في بعض مناطق العالم كان يتم الزواج بصورة جماعية، بأن يتزوّج عدد من رجال طائفة ما، بعدد من نساء طائفة أخرى. ففي التبت مثلاً كانت العادة السائدة هي أن يتزوّج عدد من الإخوة عدداً مساوياً من الأخوات بصورة لا يحدّد فيها زوجة كل فرد منهم بل يعيشون نوعاً من الشيوعية في الزواج، ويستطيع أي من الرجال أن يواقع أيّاً من النساء المذكورات. وأشار (سزار) قيصر الروم إلى عادة مماثلة كانت منتشرة بين الانجليز القدماء. ويمكن اعتبار عادة الزواج من زوجة الأخ بعد وفاة زوجها، من بقايا هذه العادات، وهو ما كان شائعاً بين اليهود وبعض الشعوب القديمة).
نظرية أفلاطون
ما يفهم من كتاب جمهورية أفلاطون، ويؤيّده عامة المؤرّخين أنّ أفلاطون يقترح - في نظرية (الحكّام الفلاسفة والفلاسفة الحكّام) - أن تعيش هذه الطبقة حياة عائلية مشتركة، وكما نعلم أنّ بعض زعماء
الشيوعية في القرن التاسع عشر كانوا قد اقترحوا اقتراحاً مشابهاً ولكن على ما ينقل كتاب (فرويد وتحريم الزواج بالمحارم) فإنّ بعض الدول الشيوعية الكبرى - وعلى أثر التجارب المرّة في هذا الباب - قد أقرّت في عام 1938 قانون الزوجة الواحدة الإجباري واعتبرته النظام الرسمي الوحيد للزواج.
تعدّد الأزواج
وهذا شكل آخر من أشكال تعدّد الزيجات، ويعني أن يكون لامرأة واحدة أكثر من زوج في نفس الوقت. يقول ويل ديورانت: (نرى هذا النوع من الزواج لدى قبيلة تودا وبعض قبائل التبت).
النوع الأول هو النوع الموجود هذه الأيام، وهو أن يخطب الرجل البنت إلى أبيها ويتزوّج منها بعد تعيين مقدار مهرها. والولد الذي تنجبه معروف الأب طبعاً.
النوع الثاني: هو أنّ الرجل خلال فترة زواجه من المرأة يسهل لها الزواج من رجل آخر لفترة معيّنة من أجل أن تلد له ولداً أفضل؛ ولذا فهو يتجنّب الاتصال بها - بعد أن يوصيها بأن تضع نفسها تحت تصرّف الشخص المطلوب - حتى يظهر عليها الحمل.
كان هذا يحصل حين يرغب شخص في أن يحصل على نسل أفضل من نسله هو، ويعتبرونه وسيلة لتحسين النسل. وهذا النوع من الزواج يسمّى (زواج الاستبضاع).
أمّا النوع الثالث من الزواج: فهو أن يتفق عدد من الرجال (أقل من عشرة) مع امرأة ويواقعونها فإذا حملت وولدت دعت أولئك الرجال للحضور ولا يستطيع أي منهم التخلّف عن الحضور طبقاً لسنن ذلك الزمان، فتختار المرأة هي مَن ترغب فيه من بينهم ليكون أباً لولدها وليس بإمكانه أيضاً أن يمتنع عن القبول، وعلى هذا الأساس يصبح الولد ابنه رسميّاً وقانونياً.
والنوع الرابع من الزواج: كان يتم مع المرأة التي تُعرف بـ (الفاحشة)، ويستطيع أي رجل بدون استثناء أن يتصل بها، ومثل هؤلاء النسوة كن يرفعن على بيوتهن أعلاماً يعرفن بها، فإذا وضعت إحداهن ولداً جمعت كل الرجال الذين سبق أن واقعوها واستدعت كاهناً أو عرّافاً. ليعطي رأيه في نسبة الولد إلى أي واحد من أولئك الرجال فيكون ذلك الرجل مجبراً على قبول رأي العرّاف، ويصبح الولد ولداً رسميّاً وقانونياً له.
كل هذه الأنواع من الزواج كانت سائدة في الجاهلية إلى أن اختار الله محمّداً (صلّى الله عليه وآله) للرسالة فألغى كل تلك الأنواع ما عدا ما هو سائد اليوم.
ومن هذا نفهم أنّ عادة تعدّد الأزواج كانت موجودة لدى عرب الجاهلية.
يقول مونتسكيو في (روح القوانين): (شاهد الرحّالة العربي أبو ظهير الحسن هذه العادة (تعدّد الأزواج) في القرن السابع الميلادي لدى زيارته للهند والصين، فعلاً، ذلك دليلاً على انتشار الفحشاء). وكتب
أيضاً: (تعيش على سواحل (مالايار) قبيلة اسمها نائير، لا يسمح لرجالها بالزواج من أكثر من امرأة بينما يسمح لنسائها أن يتزوّجن من عدّة رجال في آن واحد. واعتقد أنّ سبب تشريعهم لهذا القانون أنّ رجال قبيلة نائير من أقوى رجال القبائل شوكة، وهم - بسبب أصالتهم - مقاتلون أشدّاء. وكما نمنع - نحن في أوروبا - جنودنا من الزواج لئلاّ تعوقهم زوجاتهم عن التوجّه إلى الحرب، كذلك عملت قبائل (مالايار) على إضعاف العلاقات العائلية بين أفرادها قدر الإمكان، ولما لم يكن بوسعها منعهم تماماً من الزواج - بسبب الجو الحار هناك - عمدت إلى أن تجعل لكل مجموعة من الرجال زوجة واحدة لإضعاف الروابط الأُسرية ودفع الأفراد إلى القتال).
عيب تعدّد الأزواج
العيب الرئيس في تعدّد الأزواج والذي تسبّب في عدم نجاحه هو اختلاط الأنساب؛ إذ إنّ علاقة الأب بالولد في هذا النوع من الزواج غير واضحة تماماً كما هو الحال في الشيوعية الجنسية. وكما أنّ الشيوعية الجنسية فشلت في أن تتخذ لها موقعا في المجتمع، كذلك تعدّد الأزواج فشل في أن يلقى قبول المجتمع الحقيقي. وكما سبق أن ذكرنا في إحدى المقالات السابقة من أنّ تأسيس العش الزوجي من أجل ربط الجيل السابق بالجيل اللاحق مطلب غريزي للإنسان، فلا يعني هذا أنّ ظهور حالة تعدّد الأزواج أحياناً وبصورة استثنائية لدى بعض المجموعات
البشرية دليل على أنّ تشكيل العائلة الخاصة ليس من طبيعة الإنسان. كما أنّ اختيار الرجال أو النساء لحياة العزوبة وعزوفهم عن الحياة الزوجية لا يقوم دليلاً على انحرافهم أو على كون البشر كلّهم عازفين عن الحياة الزوجية والعائلية. وتعدّد الأزواج لا يتنافى والطبيعة الاحتكارية للرجل تجاه ولده فحسب، بل يتنافى وطبيعة المرأة في الوقت نفسه. وقد أثبتت التجارب النفسية أنّ المرأة أكثر من الرجل رغبة في الزوج الواحد.
(2) تعدّد الزوجات
والنوع الآخر من تعدّد الزيجات هو تعدّد الزوجات. وقد حاز تعدّد الزوجات هذا على رواج ونجاح أكثر ممّا حازه تعدّد الأزواج، وما حازته الشيوعية الجنسية. ولم يقتصر وجوده على القبائل البدائية، بل شمل كثيراً من المجتمعات المتحضّرة؛ فقد كانت هذه العادة - علاوة على وجودها عند عرب الجاهلية - موجودة لدى اليهود ولدى الشعب الإيراني على عهد الساسانيين، ولدى بعض الشعوب الأخرى أيضاً.
ويقول منتسكيو: (كان قانون الملايو يبيح الزواج من ثلاث نساء). ويقول أيضاً: (أجاز فالانتين إمبراطور روما - لأسباب خاصة - زواج الرجل من عدّة نساء في وقت واحد، ولكن لما كان هذا القانون لا ينسجم مع المناخ الأوروبي فقد رفضه باقي أباطرة الروم مثل (تيودور) و(آكارديوس) و(مونوريوس).
الإسلام وتعدّد الزوجات
لم يلغ الإسلام نظام تعدّد الزوجات بالمرّة - على العكس من موقفه من نظام تعدد الأزواج - بل حدّده وقيّده، فمن جهة جعل له حداً أعلى (هو أربع زوجات)، ومن جهة أخرى وضع له قيوداً وشروطاً ولم يبحه لكل مَن أحب وأراد. وسنبحث هذه القيود والشروط، وكذلك السبب الذي من أجله لم يلغ الإسلام هذا النوع من الزواج - بشكل مطلق - فيما بعد.
والعجيب أنّ من جملة الإشاعات التي أطلقها أعداء الإسلام ضدّه في القرون الوسطى هي: أنّ نبي الإسلام (صلّى الله عليه وآله) هو الذي ابتدع ولأوّل مرة عادة تعدّد الزوجات!! وادعوا أنّ الإسلام قد بُني على نظام تعدّد الزوجات، وأنّ سبب انتشاره السريع بين الأمم والشعوب لم يكن إلا لسماحه بتعدّد الزوجات، وادعوا في الوقت ذاته أنّ سبب تأخّر الشرق هو تعدّد الزوجات أيضاً.
ذكر ويل ديورانت في الجزء الأول من تاريخ الحضارة في الصفحة 61 ما يلي: (كان علماء الدين في القرون الوسطى يدّعون أنّ تعدّد الزوجات من ابتكار نبي الإسلام، بينما الحقيقة هي خلاف ذلك. فإنّ أكثر حالات الزواج في المجتمعات البدائية كانت على هذه الصورة، كما رأينا.
والأسباب التي أدّت إلى تعدّد الزوجات في المجتمعات البدائية
كثيرة؛ وذلك لانشغال الرجال بالحرب والصيد ممّا كان يعرض حياتهم إلى الأخطار، فكانت الوفيات في الرجال أكثر منها في النساء ممّا جعل عدد النساء يزيد على عدد الرجال، وأدّى بالتالي إلى أن يسود نظام الزوجات أو بقاء الكثير من النساء عازبات، ولما كانت عوامل الموت والفناء كثيرة في تلك المجتمعات، فليس من المنطق أن تبقى أعداد كبيرة من النساء بدون زواج، وكان تعدّد الزوجات في المجتمعات البدائية أمراً مألوفاً؛ وذلك لزيادة عدد النساء على عدد الرجال.
أمّا من حيث تحسين النسل، فيجب القول أيضاً: إنّ أسلوب تعدّد الزوجات يفضّل الزوجة الواحدة بالرغم ممّا نعلمه من أنّ الأقوياء والأكفّاء من الرجال في العصر الحاضر غالباً ما يتزوّجون في وقت متأخّر من حياتهم، ولذا نراهم قليلي الأولاد، إلاّ أنّ أقوياء الرجال في العصور الغابرة كانوا يحصلون على أفضل النساء - كما يظهر - فيلدن لهم - بالنتيجة - أعداداً كبيرة من الأولاد وهذا ما أدّى إلى بقاء نظام تعدّد الزوجات عند الشعوب البدائية، بل الشعوب المتحضّرة أيضاً: أمّا في عصرنا الحاضر فهناك عوامل عديدة حدت بهذه العادة إلى الزوال والانحسار عن الدول الشرقية.
إنّ حياة الزراعة تتميّز بالثبات والاستقرار، ممّا قلّل من الصعوبات التي كان يواجهها الرجال، وخفّف من الأخطار التي كانوا يتعرّضون لها؛ لذا أصبح عدد الرجال مساوياً تقريباً لعدد النساء، وانحصرت عادة
تعدّد الزوجات - حتى لدى المجتمعات البدائية - في الأقلّية الثرية في المجتمع بينما اقتصر أكثر الرجال على زوجة واحدة وصاروا يطعّمون حياتهم الزوجية بـ (الزنا) أحياناً.
ويقول (غوستاف لوبون) في (تاريخ الحضارة) صفحة 507:
(لم يعب الأوروبيون على الشرقيين عادة كما عابوا عليهم عادة تعدّد الزوجات، ولم يخطئوا في أمر كما أخطأوا في هذا الأمر. فقد عدّ كتّاب أوروبا تعدّد الزوجات أساس الدين الإسلامي واعتبروه علّة العلل في انتشار الدين الإسلامي وتأخّر الشعوب الشرقية. ثم إنّهم بالإضافة إلى كل ذلك، قد أظهروا عطفهم على حال النساء الشرقيات. وممّا يذكرونه في هذا الباب أنّ أولئك النسوة التعيسات قد حُبسن بين أربعة جدران تحت سيطرة مالكيهن، وإذا ما بدرت منهنّ أيّة حركة توجب سخط المال، فمن الممكن أن يعدمن بكل قسوة. ولكنّ التصوّر المذكور ليس له أي أساس من الصحّة، ولو أنّ قرّاء هذا الكتاب من الأوروبيين قد تخلّوا عن تعصّبهم الأوروبي لفترة من الوقت ولو قصيرة؛ لأدركوا أنّ عادة تعدّد الزوجات أمر مناسب جداً للوضع الاجتماعي في الشرق.
والعامل الأساس في رقي الأُمم التي كانت سائدة بينها، وهي التي وطّدت أواصر العائلة لديها، وبالتالي كانت هي السبب في عزّة المرأة الشرقية وكرامتها. وقبل أن أبدأ بإقامة الدليل على كلامي هذا، لابدّ أن
أذكر أنّ عادة تعدّد الزوجات لا ترتبط بالإسلام أبداً، إذ إنّها كانت شائعة قبل الإسلام بين جميع شعوب الشرق من اليهود والإيرانيين والعرب وغيرهم. والشعوب التي اعتنقت الإسلام في الشرق لم تكتسب هذه العادة من الإسلام، كما أنّه لم يظهر في العالم لحدّ الآن مذهب يمتلك القدرة على إيجاد أو إبطال عادة مثل عادة تعدّد الزوجات؛ لأنّها لم تتولّد إلاّ نتيجة المناخ الشرقي والخصائص العرقية لشعوب الشرق، ولأسباب أخرى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بطراز الحياة الشرقية، وليس لظهور الدين... ومع أنّ المناخ والماء والهواء في الغرب لا يقتضي نشوء مثل هذه العادة، فإنّ القانون ينصّ - في إحدى مواده - على عدم جواز الزواج بأكثر من واحدة. لكنّ هذه المادة القانونية هي حبر على ورق لا غير، إذ لا أثر لها في الواقع والتطبيق. إنّني حائر لا أدري لماذا يُعدّ تعدّد الزوجات الشرقي - مع مشروعيّته - جنحة وتقصيراً، ولا يُعدّ تعدّد الزوجات الغربي غير القانوني كذلك؟ إنّني أرى أنّ الأول أفضل وأليق من الثاني من جميع الوجوه. وحين يزور بلادنا العظيمة أهل الشرق، يعجبون لهذه الحملات التي تشن ضدّ عاداتهم، وينزعجون...).
نعم، إنّ الإسلام لم يبتدع تعدّد الزوجات، إنّما حدّده، وجعل له حدّاً أعلى، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، وضع له قيوداً وشروطاً ثقيلة. وقد كانت هذه العادة سائدة بين الأمم والشعوب التي اعتنقت الإسلام فاضطرّوا - مرغمين - إلى قبول القيود والحدود التي فرضها الإسلام عليهم.
تعدّد الزوجات في إيران
ذكر كريستنسن في كتاب (إيران في زمان الساسانيين)(1) ما ترجمته: (كان مبدأ تعدد الزوجات يعد الأساس في تشكيل العائلة (في إيران زمن الساسانيين). وعلى هذا الأساس كان للرجال أن يتزوج من النساء ما وسعه. والظاهر أنّ الرجال المحدودي الدخل لم يكن لهم أكثر من زوجة واحدة. وكان للرجل الحق في ترؤّس العائلة.
وكانت الزوجات على نوعين: الأُولى: محبوبة ومفضّلة وتمنح حقوقاً ممتازة وتسمّى الملكة (پادشاه زن) أو المرأة المختارة. والثانية: أدنى من الأُولى وقد جعلت للخدمة وتسمّى الخادمة (زن چگاريها)، وتتباين حقوق كل من النوعين قانوناً. والظاهر أنّ الجواري والسبايا هنّ من طبقة الخادمات. ولا نعلم هل كان عدد النساء الممتازات اللواتي يمكن أن يتزوّجهن الرجل الواحد محدّداً أم لا. ولكن ورد في كثير من المباحث القانونية كلام يدور حول الرجل الذي له أكثر من زوجة ممتازة. وتحمل كل من نساء هذه الطبقة، لقب سيدة البيت ويقال: إنّه كان لكل منهن بيت مستقل. والزوج مكلّف ما دام حيّاً بإطعام زوجته الممتازة ورعايتها ويتمتّع كل ابن إلى سن البلوغ، وكل بنت إلى سن الزواج بنفس هذه الحقوق أمّا الزوجات اللواتي كنّ يحملن لقب الخادمات فأولادهن الذكور فقط يتمتعون بحق العيش في كنف
____________________
(1) بالفارسية (إيران در زمان ساسانيان) ص 346.
والدهم). ويكتب المرحوم سعيد نفيسي في كتابه (التاريخ الاجتماعي لإيران منذ انقراض الساسانيين إلى انقراض الأمويين)(1) فيقول: (كان عدد النساء اللواتي يمكن للرجل الاقتران بهن غير محدود، وقد عثر في الوثائق اليونانية على ما يدل بأنّ الرجل قد يجمع في بيته أحياناً عدّة مئات من النساء).
وينقل مونتسكيو في (روح القوانين) عن (اوكاتيوس) المؤرّخ الروماني قائلاً: (في زمان جوستنيان، تعرّض عدد من فلاسفة الرومان إلى الاضطهاد من قبل المسيحيين، ولما لم يرغبوا في اعتناق الدين المسيحي اضطرّوا إلى مغادرة روما واللجوء إلى بلاط خسرو پرويز شاه إيران آنذاك، وهناك كان ما أثار حيرتهم وعجبهم أكثر من أي شيء آخر هو ليس شيوع تعدّد الزوجات فحسب بل مواقعة الرجال لنساء الآخرين أيضاً).
ولابد من الإشارة هنا إلى أنّ الفلاسفة الرومان المذكورين كانوا قد لجأوا إلى بلاد أنوشيروان لا إلى خسرو پرويز , وقد ورد ذكر خسرو پرويز في حديث مونتسكيو خطأً.
ولم يكن لتعدّد الزوجات حد أعلى عند العرب. وقد أدّى تحديد الإسلام لعدد الزوجات ووضعه حدّاً أعلى لذلك إلى التضييق على
____________________
(1) بالفارسية: (تاريخ اجتماعي إيران از انقراض ساسانيان تا انقراض أمويان).
بعضهم إذ كان له أكثر من أربع زوجات. وقد كان للبعض عشر زوجات ممّا اضطرّهم إلى تسريح ستٍّ منهن.
إذاً، فقد تبيّن أنّ الإسلام لم يبتدع تعدّد الزوجات بل على العكس من ذلك جعل له حدوداً وقيوداً، لكنّه لم يلغه كلّيّاً في الوقت نفسه.
وسنطلع في الفصول القادمة على سبب ظهور مسألة تعدّد الزوجات في حياة الإنسان، وهل كان ذلك بسبب ظلم أو تعسّف الرجل تجاه المرأة أم أنّ ضرورات خاصة قد أوجبت هذا الأمر؟ وما هي هذه الضرورة إن وُجدت؟ وهل هي من نوع العوامل البيئية الجغرافية أم من نوع آخر؟ وأخيراً لماذا لم يلغ الإسلام هذه العادة؟ وما هي الحدود التي وضعها الإسلام لتعدّد الزوجات؟ وما هي الأسباب التي دعت البشر اليوم نساءً ورجالاً إلى معارضة تعدّد الزوجات؟ وهل هناك جذور إنسانية وأخلاقية للمسألة أم شيء آخر؟
هذه الأمور هي التي سنتعرّض لها في الفصل القادم.
الأسباب التاريخية لتعدّد الزوجات (1)
ما هي الأسباب التاريخية والاجتماعية لتعدّد الزوجات؟ لماذا تقبل الكثير من شعوب العالم (خصوصاً شعوب الشرق) هذه العادة بينما رفضتها شعوب أخرى كالشعوب الغربية؟ لماذا راج - من بين الأنواع الثلاثة لتعدد الزواج - تعدّد الزوجات بخلاف تعدّد الأزواج
والاشتراكية الجنسية اللذين إمّا أنّهما لم يؤخذ بهما أصلاً، وإمّا أنّهما قد حصلا بصورة نادرة جدّاً وفي حالات استثنائية؟
وما لم نبحث هذه النقاط لن نتمكّن من بحث مسألة تعدّد الزوجات في نظر الإسلام، ولا بحث حاجة البشرية اليوم إليها.
ولو أنّنا أردنا أن نتجاهل الدراسات النفسية والاجتماعية المعنيّة بهذا الأمر ونفكّر بطريقة سطحية ككثير من الكتّاب لكفانا - من أجل توضيح العوامل التاريخية والاجتماعية لتعدّد الزوجات - أن نكرّر العبارة المعروفة التي تردّدها الألسن دائماً في مثل هذه الموارد، ونقول: إنّ سبب نشوء تعدّد الزوجات جلي جداً. وما ذاك إلاّ لاستبداد الرجل وظلمة واستعباده المرأة وما سببه إلا لأنّ الرجل - بسبب تسلّطه على المرأة - قد سنّ قوانين وعادات تخدم مصالحه هو؛ لذا فقد شرّع قانون تعدّد الزوجات لمصلحته وضد مصلحة المرأة وطبقة طوال كل هذه القرون. ولما كانت المرأة محكومة للرجل لذلك لم تستطع أن تسن - لمصلحتها - قانوناً يسمح لها بتعدّد الأزواج.
واليوم وبعد أن انتهى عهد سيطرة الرجل وتسلّطه، فإنّ امتياز تعدّد الزوجات قد استبدل - كغيره من الامتيازات الظالمة - بقانون التساوي والتماثل في الحقوق بين المرأة والرجل.
لو كنّا نفكّر بهذه الطريقة، لكنّا قد فكّرنا بشكل سطحي وساذج جدّاً. فليس سبب رواج تعدّد الزوجات هو ظلم الرجل، ولا سبب ضعف
وتبعيّة المرأة هو فشل تعدّد الأزواج، كما وليس زوال تعدّد الزوجات اليوم وانحساره عن الواقع العملي ناتجاً عن زوال سلطة الرجل أو فقدانه لامتياز تعدّد الزوجات، بل على العكس من ذلك، إذ قد اكتسب امتيازاً تجاه المرأة.
إنّني لا أنكر أنّ عامل الظلم والتسلّط من العوامل المؤثّرة في التاريخ الإنساني، ولست أنكر كون الرجل قد أساء استخدام حكمه للمرأة طوال التاريخ. لكنّني أعتقد أنّ الاقتصار على عامل القوّة والتسلّط - خصوصاً في تفسير العلاقات العائلية للمرأة والرجل - نابع من القصور الفكري.
إنّنا لو قبلنا النظرية السابقة، لوجب علينا أن نقبل فكرة أنّ العهود النادرة والاستثنائية التي ساد فيها أُسلوب تعدّد الأزواج - كزمان جاهلية العرب، أو الفترة التي مرّت بقبيلة نائير على سواحل الملايو كما يذكر مونتسكيو - هي عهود سنحت فيها الفرصة للمرأة كي تنتزع السلطة من يد الرجل وتفرض عليه نظام تعدّد الأزواج، ويجب أن نقبل فكرة كون هذه العهود هي عهود ذهبية للمرأة. بينما نحن نعلم أنّ زمان جاهلية العرب كان من أحلك الفترات التي عاشتها المرأة. كما نقلنا في المقالة السابقة عن مونتسكيو أنّ رواج تعدّد الأزواج عند قبيلة نائير لم يكن نابعاً من تسلّط واحترام المجتمع للمرأة، بل كان منشؤه تصميم المجتمع على إبعاد الجنود عن العلاقات العائلية للمحافظة على الروح القتالية.
يضاف إلى ذلك أنّ تعدّد الزوجات إن كان ناشئاً عن تسلط الأب، فلماذا لم يسد أو ينتشر بين الشعوب الغربية؟ فهل كان تسلط الأب مقتصراً على شعوب الشرق؟ وهل كان الغربيون على خطى عيسى ومريم ليجعلوا للمرأة والرجل حقوقاً متساوية؟ وهل كانت السلطة في الشرق فقط بيد الرجل ولمصلحته بينما كانت العدالة في الغرب هي السائدة.
إنّ المرأة الغربية كانت - إلى ما قبل نصف قرن - من أتعس نساء العالم. وكانت محتاجة إلى قيمومة الرجل حتى في أموالها، وباعتراف الغربيين أنفسهم، فإنّ وضع المرأة الشرقية في القرون الوسطى كان أفضل بكثير من وضع المرأة الغربية. يقول غوستاف لوبون: (في خلال فترة الحضارة الإسلامية، منحت المرأة نفس الدرجة والمقام اللذين لم يعطيا للمرأة الأوروبية إلاّ بعد فترة طويلة جداً. أي بعد أن قام عرب الأندلس بنشر أخلاق الفرسان في أوروبا... فإنّ أخلاق الفرسان عند الأوروبيين - والتي يشكّل التعامل مع المرأة الجزء الأهم فيها - إنّما جاءت من المسلمين وأخذت عنهم، وأنّ الدين الذي استطاع أن يرفع المرأة من الذلة والمهانة إلى أوج العزّة والرفعة هو الدين الإسلامي، وليس الدين المسيحي كما يتصوّر العامة. ذلك أنّنا نرى رؤساءنا وقادتنا في القرون الوسطى - بالرغم من أنّهم كانوا مسيحيين - لم يكونوا يقيمون وزناً للمرأة. ولو طالعنا التاريخ القديم لما بقيت شبهة في أنّ هؤلاء القادة الأُمراء - قبل أن يتعلّموا من المسلين احترام ورعاية
المرأة - كانوا يعاملونها بكل وحشية).
وقد وصف آخرون أوضاع المرأة الغربية في القرون الوسطى بما يشبه هذا. ومع أن تسلّط الرجل وظلمه وسيطرته كانت قد بلغت أوجها في أوربا في القرون الوسطى، فلماذا لم يكن تعدّد الزوجات سائداً آنذاك؟
الحقيقة هي أنّ تعدّد الأزواج لم يكن ناتجاً عن قوّة وتسلّط المرأة، ولم يكن فشله ناتجاً عن ضعفها وتخاذلها، كما لم يكن سبب رواج تعدّد الزوجات في الشرق قوّة وتحكّم الرجل، ولا كان عدم رواجه في الغرب ناتجاً عن قوّة المرأة وتساويها مع الرجل.
سبب فشل تعدّد الأزواج
إنّ سبب فشل تعدّد الأزواج هو تنافيه مع طبيعة كل من المرأة والرجل على حدٍّ سواء. أمّا بالنسبة للرجل فهو يتنافى مع النفسية الاحتكارية له أوّلاً، ومع مبدأ الاطمئنان للبنوّة ثانياً. فحب الولد من طبيعة البشر. والإنسان يحب - بطبعه - أن يكون له ولد، ويريد أن تكون صلته بالجيل اللاحق والجيل السابق واضحة ومطمئنّة. إنّه يريد أن يعرف أنّه ابن مَن، ووالد مَن، بينما تعدّد الأزواج للمرأة الواحدة في آن واحد لا ينسجم مع هذه الغريزة والطبيعة الإنسانية، بخلاف تعدّد زوجات الرجل فهو لا يسيء - من هذه الناحية - إلى الرجل ولا إلى المرأة.
يقال إن عدداً من النساء (في حدود الأربعين امرأة) حضرن عند علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وتساءلن: لماذا أجاز الإسلام للرجل تعدّد الزوجات ولم يجز للنساء تعدّد الأزواج؟ أليس هذا تمييزاً مجحفاً؟
فأمر علي (عليه السلام) بأن يؤتى بأوان صغيرة مملوءة بالماء، وأعطى كل واحدة منهن إناءً منها، وأمرهن بسكب مياه تلك الأواني في إناء كبير كان قد وضع في وسط المجلس. بعدها، قال: لتستعد كل منكن الماء الذي سكبته على أن يكون نفس الماء الذي كان في إنائها. قلن كيف يمكن ذلك؟ لقد اختلطت المياه ببعضها ولا يمكن تعيين ماء كل إناء وعزله من جديد. عندها قال (عليه السلام): إنّ المرأة المتزوّجة من عدّة رجال في آن واحد، ستلتقي بجميعهم ثم تحمل، فكيف يمكن تشخيص مَن هو أبو الطفل القادم من بين هؤلاء الرجال. هذا من ناحية الرجل. أمّا من ناحية المرأة، فتعدّد الأزواج يتنافى وطبيعة المرأة ومصلحتها، فالمرأة لا تريد الرجل لإرضاء غريزتها الجنسية وحسب (كي يقال إنّه كلما كان أكثر، كان أحسن) إنّها تريد الفوز بقلب الرجل... تريده حامياً لها ومدافعاً عنها، ثم تضحّي من أجله، وتشقى وتجمع المال وتقدّم ثمرة شقائها وكدّها فداءً له، وتشاركه همّه وغمّه. والمال الذي يدفعه الرجل للمرأة عند الزنا - وهو مال اكتسبته المرأة مقابل عمل - لن يفي بالاحتياجات الكبيرة لها والتي تفوق حاجة الرجل بعدّة أضعاف، وليست له القيمة المعنوية التي يحظى بها المال الذي يهبه الرجل لها بدافع الحب والحنان. وحاجات المرأة المتعدّدة يؤمّنها الرجل بوصفه مضحّياً من أجل المرأة.
وإنّ أقوى دافع يدفع الرجل إلى العمل والنشاط هو المؤسسة العائلية (أي الزوجة والأطفال).
والمرأة في نظام تعدّد الأزواج لا يمكنها أن تفوز بحماية ومحبّة أي واحد منهم ولا اجتذاب عواطفه الخالصة، أو دفعه للتضحية من أجلها؛ ولهذا صار تعدّد الأزواج - كالزنا تماماً - يُثير اشمئزاز المرأة دائماً. وهكذا نرى تعدّد الأزواج لا ينسجم وميول ورغبات أي من الرجل والمرأة.
فشل الاشتراكية الجنسية
إنّ كلّ ما ذكرناه سابقاً هو سبب فشل الاشتراكية الجنسية أيضاً. والاشتراكية الجنسية أو زوال اختصاص رجل بامرأة معينة واختصاص امرأة برجل معيّن كانت قد اقترحت - كما ذكرنا - من قبل أفلاطون، إلاّ أنّه كان قد طرحها في حدود الطبقة الحاكمة. أي طبقة الحكّام الفلاسفة والفلاسفة الحاكمين حسب اصطلاحه. هذا الاقتراح لم يفشل في الحصول على استحسان الآخرين وحسب، بل إنّ أفلاطون نفسه قد عدل عنه في النهاية.
وقد اقترح فردريك إنجلز - الأب الثاني للشيوعية في القرن الأخير - هذه النظرية ودافع عنها. إلاّ أنّ العالم الشيوعي رفضها، ويقال إنّ الحكومة السوفيتية (على إثر تجارب مرّة ومتعدّدة نتيجة تطبيق نظرية العائلة الاشتراكية لإنجلز) قامت في سنة 1938 بسنّ قوانين
تؤيّد قيام العائلة وتعتبر الاقتران بزوجة واحدة هو الزواج الرسمي الشيوعي.
إنّ تعدّد الزوجات يمكن أن يُعدّ امتيازاً للرجال، أمّا تعدّد الأزواج فلا يمكن اعتباره ميزة للمرأة لا سابقاً ولا لاحقاً. والسبب في ذلك أنّ الرجل يطلب جسد المرأة أمّا المرأة فتريد امتلاك قلب الرجل وتضحياته، وما دام جسد المرأة بين يدي الرجل فلا يهمّه ألاّ يكون قلبها كذلك؛ ولذا لا يهم الرجل في حال تعدّد الزوجات أن يخسر قلب الزوجة وعواطفها، بينما تعتبر المرأة قلب الرجل وعواطفه لبّ المسألة، فإذا خسرتهما فقد خسرت كل شيء.
وبتعبير آخر: إنّ هناك عنصرين يتدخّلان في أمر الزواج: أحدهما مادي والآخر معنوي. أمّا الجانب المادي في الزواج فهو الجانب الجنسي الذي يبلغ أوج عنفوانه في فترة الشباب ثم يجنح تدريجياً إلى البرود ثم الانطفاء. بينما يتلخّص جانبه المعنوي في العواطف الرقيقة الخالصة التي تحكم علاقتهما وهي تزداد أحياناً وتقوى على مرّ الزمان. ومن الفوارق بين المرأة والرجل أنّ الجانب الثاني أهم عند المرأة من الأوّل على العكس من الرجل. والمرأة تهتم بالجانب المعنوي للزواج بينما يهتم الرجل بالجانب المادي منه، أو يتساوى عنده الجانبان على الأقل.
وبالإضافة إلى هذا فقد أوردنا في المقالة الرابعة والعشرين حديثاً
عن إحصائية نفسانية أوروبية شاهداً على كلامنا في أنّ المرأة لكونها حاضنة للطفل في رحمها وحجرها فهي تعيش حالة نفسية خاصة تجعلها في أمسّ الحاجة إلى حب ورعاية والده، كما أنّ مقدار حب الأم لأطفالها يرتبط إلى حدٍّ كبير بمقدار حبّها وتعلّقها بأبيهم لكونه عاملاً في إنجابهم. هذه الحاجة النفسية عند المرأة لا تشبع إلاّ في ظل الزواج الواحد.
وعلى هذا فمن الخطأ المحض اعتبار تعدّد الزواج في منزلة وحدة مع تعدد الزوجات وعدم التمييز بينهما، وتصوّر أنّ سبب نجاح تعدّد الزوجات في بعض مناطق العالم هو قوّة وتسلّط الرجل هناك، وإنّ فشل المرأة في تطبيق نظام تعدّد الأزواج نابع من ضعفها وتخاذلها.
تقول السيدة منوچهريان في كتاب (نقد القوانين الأساسية والمدنية الإيرانية) في الصفحة 34 ما يلي: (جاء في المادة 1049 من القانون المدني: (ليس لإحدٍ أن يتزوّج من ابنة أخي زوجته أو ابنة أختها إلاّ بإجازة الزوجة... فإذا أجازت زوجته كان له أن يتزوّج ابنة أخيها أو ابنة أُختها).
والآن لننظر ماذا يحدث لو أنّها لم تجز ذلك؟ لن يتغيّر شيء في الأمر طبعاً.. فالمثل يقول إذا حصل العوض رُفع العتب، فالذي سيحصل هو أنّ الرجل إذا لم يتزوّج من أولئك فسيتزوج من غيرهن. والآن لنعكس القضية وننظر ماذا سيحصل؟ كأن نقول - مثلاً - أن ليس للمرأة أن تتزوّج من ابن أخي أو ابن أخت زوجها (في نفس الوقت الذي تكون
فيه زوجة له) إلاّ بإذن الزوج. عندها يثور الدم في العروق المتعصّبة وتعلو الأصوات قائلة: إنّ هذا الأمر مخالف للمبادئ الإنسانية، ومخالف أصلاً لطبيعة ودور المرأة. ونحن نجيب على ذلك بالقول: إنّه لا يخالف إلاّ مبدأ استرقاق المرأة. فكما أنّ المال لا يكون ملكاً إلاّ لمالك واحد وإذا كان له أكثر من مالك فإنّه سيعود بالنتيجة بعد التقسيم إلى مالك واحد، كذلك المرأة - وبصريح قوانين بلدنا (أو بصورة ضمنية) حكمها حكم المال - لا يمكن أن يكون لها أكثرمن مالك واحد...).
وتقول في الصفحة 73 من الكتاب: (نستطيع أن نقول: بما أنّ للرجل أن يتزوّج أربع نساء، فكذلك يجب أن يكون للمرأة - باعتبارها بشراً مساوياً للرجل - نفس حقوق الرجل. والنتيجة المنطقية لهذه الصغرى والكبرى تخيف الرجال؛ إذ يغلي الدم في عروقهم ويصرخون والشرر يتطاير من أعينهم وقد احمرّت وجوههم، قائلين: كيف يمكن أن يكون للمرأة أكثر من زوج؟ وهنا نجيبهم بكل برود: ولماذا يكون الرجل أكثر من زوجة؟ (ونحن لا نقصد هنا أن ندعو إلى إشاعة الفساد الأخلاقي، ولا نريد الإساءة إلى عفّة وطهارة المرأة، لكنّنا نريد أن نفهم الرجال، إن رأيهم في المرأة لم يقم على أساس متين. المرأة إنسان والرجل إنسان، وهما متساويان فإذا أُعطي للرجل الحق في الزواج من أربع فيجب أن يُعطى للمرأة نفس هذا الحق. فلو فرضنا أنّ عقل المرأة لا يرجّح على عقل الرجل. إلاّ أنّنا يجب أن نقرّ بأنّ سبحاتها الروحية وعواطفها الإنسانية لا تقل عمّا يتمتّع به الرجل).
يلاحظ - في الحديث الذي مرّ - عدم افتراض أي فرق بين تعدّد الزوجات وتعدّد الأزواج، سوى ذكره أنّ الرجل قد فرض لنفسه تعدّد الزوجات، بخلاف المرأة التي لا تملك الحرية في الدفاع عن مبدأ تعدّد الأزواج الذي يشكّل وحده عنوان حريتها. كما ورد سابقاً من أنّ سبب نجاح تعدّد الزوجات وفشل تعدّد الأزواج هو مالكية الرجل ومملوكية المرأة، فالرجل لكونه مالكاً للمرأة استطاع أن يمتلك عدّة نساء بمعنى عدّة مملوكات، أمّا المرأة فإنّها مملوكة، وبما أنّ المملوك لا يكون له أكثر من مالك واحد، فقد حرمت لذلك من نعمة تعدّد الأزواج.
ومن عجيب الصدف أنّ الأمر على خلاف رأي السيدة الكاتبة؛ لأنّ رفض تعدّد الأزواج بحد ذاته دليل على أنّ الرجل لا ينظر إلى المرأة كسلعة أو شيء ممّا يمتلك؛ إذ الاشتراك في الأموال وملكية أكثر من شخص لشيء ما والتصرّف فيه مشتركاً أمر طبيعي ومعروف في كل قوانين البشر على وجه الأرض. ولو أنّ الرجل نظر إلى المرأة على أنّها ملك ومال؛ لرضي أن يشاركه غيره في تملّكها كما يرضى لغيره أن يشاركه في ملكية الأشياء. حيث لا نجد في الدنيا مكاناً يرفض اشتراك المالكين في ملكية شيء ما، كي نقرّر أنّ تعدّد الزوجات مبني على هذا الأساس.
إنّها تقول: إنّ الرجل إنسان والمرأة إنسان لذا يجب أن يتمتعا بحقوق متساوية، فلماذا يتمتّع الرجل بحق تعدّد الزوجات، ولا تتمتّع
المرأة بنفس الحق في تعدّد الأزواج؟
وأقول: إنّ الخطأ يكمن في تصوّرك أنّ تعدّد الزوجات حقٌّ من حقوق الرجل، وتعدّد الأزواج حق من حقوق المرأة. والحقيقة هي أنّ تعدّد الزوجات هو من حقوق المرأة بينما تعدّد الأزواج لا من حقوق الرجل ولا من حقوق المرأة؛ لأنّه ليس في صالح الرجل ولا في صالح المرأة. وسنبرهن فيما بعد على أنّ قانون تعدّد الزوجات في الإسلام إنّما جاء لإحياء وإحقاق حقوق المرأة. ولو كان الإسلام يريد مراعاة جانب الرجل لفعل ما يفعله العالم الغربي، إذ يعطي للرجل حق ممارسة الجنس مع غير امرأته، ثم لا يفرض عليه أي التزام تجاهها ولا تجاه أولاده منها من الناحية القانونية.
إنّ تعدّد الأزواج ليس في صالح المرأة كي يُعد حقّاً مسلوباً منها.
ثم تقول الكاتبة: (أريد أن أُفهم الرجال أنّ رأيهم في المرأة ليس قائماً على أساس متين). وهذا ما نطلبه نحن أيضاً. وسنوضّح في المقالات التالية أساس نظرية الإسلام في تعدّد الزوجات، ثم أطلب إلى هذه الكاتبة وإلى كل صاحب رأي أن ينظر ويقرّر هل إنّ نظرية الإسلام مبتناة على أساس متين أم لا؟ فإذا استطاع أحد أن يرينا خللاً في أساس النظرية الإسلامية في هذا الباب، فإنّني أعطيه قول شرف أن أتراجع عن كل أقوالي في هذا الموضوع.
الأسباب التاريخية لتعدّد الزوجات (2)
إنّ حب العبث وتسلّط الرجل على المرأة وحدهما لا يكفيان سبباً لنشوء تعدّد الزوجات، فلابد أن تكون هناك عوامل وأسباب أخرى أدّت إلى هذا الموضوع. الرجل العابث لا يجد طريقاً أسهل من اتخاذ العشيقات وحرية الجنس لإرضاء رغباته وشهواته؛ لأنّ ذلك لا يكلفه ما يكلفه الزواج بما يحمل من مسؤوليات تجاه المرأة المطلوبة والأولاد المنتظرين.
ولذا ففي المجتمعات التي يسودها نظام تعدّد الزوجات، إمّا أن تقف القيم الأخلاقية والاجتماعية حائلاً بين الرجل الذي يطلب التنوّع وبين ما يريد من العبث بالنساء واتخاذ العشيقات؛ فيضطر إلى دفع ضريبة رغباته وطموحاته الجنسية بقبول الزواج القانوني ومسؤولية رعاية الأطفال، وإمّا أن نفترض وجود أسباب أخرى تفرض هذا الوضع، كالعوامل الجغرافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
العوامل الجغرافية
يصر مونتسكيو وغوستاف لوبون كثيراً على أنّ للعوامل الجغرافية دخلاً في تعدّد الزوجات، ويريان أنّ مناخ الشرق يقتضي وجود هذه العادة؛ إذ إنّ المرأة في هذا الجو تصل مرحلة البلوغ في وقت مبكر وتشيخ في عمر مكبر؛ لذا يحتاج الرجل إلى زوجة ثانية وثالثة. ومن ناحية أخرى فإنّ الرجل في ظل هذا المناخ يمتلك طاقة جنسية لا ترضيها
زوجة واحدة.
يقول غوستاف لوبون في تاريخ الحضارة الإسلامية والعربية صفحة 509: (إنّ تعدّد الزوجات إنّما نشأ على أثر نوع المناخ الشرقي، ونتيجة لخصائص عنصرية وأسباب ترتبط بنوع الحياة الشرقية ولم ينشأ بتأثير الدين. إذ لا يخفى أنّ تأثير المناخ والخصائص القومية تعتبر من العوامل التي لا يمكن إنكارها في هذا المجال، فلا أرى داعياً للاسترسال في الحديث عنها أكثر من هذا. كما أنّ طبيعة وبنية النساء الشرقيات وحضانة الأطفال ووجود الأمراض وغير ذلك من العوامل؛ تجبر الرجل على أن يعتزل، صعب التحمّل من قبل الرجل، صار الأخير مضطرّاً إلى العمل بتعدّد الزوجات).
ويقول مونتسكيو في كتاب (روح القوانين) في الصفحة 430: (في البلاد ذات المناخ الحار تصل النساء سن البلوغ في الثامنة والتاسعة والعاشرة من العمر، ثم يتزوّجن بحيث يمكن القول إنّ الزواج والحمل يتمّان إثر بعضهما مباشرة).
ويتحدث (بريدف) عن نبي الإسلام (صلّى الله عليه وآله) فيقول: (إنّه قد اقترن بخديجة وهي في الخامسة من العمر ودخل بها وهي في الثامنة. ذلك أنّ نساء البلاد الحارّة يشخن في سن العشرين وحين يقترب عقلهن من الكمال، يكن قد هرمن... أمّا في البلاد المعتدلة فإنّ جمال المرأة يعمّر مدّة أطول والنساء يبلغن في سن متأخّرة وحين يتزوّجن، تكون
تجاربهن الحياتية أكثر لامتداد السن، وحين ينجبن الطفل الأول، يكون العمر قد ولّى منه الشيء الكثير، كما أنّ الزوجين يتزوجان وهما في سن متقاربة فإذا هرما، هرما معاً؛ لذا تجد المساواة بين المرأة والرجل وأنّ الرجال لا يتزوجون بأكثر من واحدة... ولهذا نقول إنّ قانون منع تعدّد الزوجات في أوربا ورواجه في آسيا مرتبطان بمقتضيات المناخ).
هذا التعليل خطأ محض
أوّلاً: لأنّ عادة تعدّد الزوجات لم تكن في أي وقت من الأوقات مقتصرة على البلاد الحارّة، ففي إيران - وهي معتدلة المناخ - كانت هذه العادة سائدة قبل الإسلام. كما أنّ ما يذكره مونتسكيو من أنّ النساء في البلاد الحارّة يهرمن في سن العشرين يُعدّ تجنّياً عليهنّ ليس إلاّ. وأكثر تجنّياً منه ما يقوله بريدف: من أنّ نبي الإسلام قد اقترن بخديجة في الخامسة وزُفّت إليه وهي في الثامنة، بينما يعلم الجميع أنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) قد تزوّج من خديجة حين كان هو في الخامسة والعشرين وكانت هي في الأربعين.
ثانياً: إذا كان هرم النساء المبكّر وغليان الرجال الجنسي هو الدافع لنشوء تعدّد الزوجات في الشرق، فلماذا لم يلجأ الشرقيون - لإشباع هذا النهم - إلى الطريقة التي اتبعها الغربيون في القرون الوسطى والحديثة بفسح المجال للفحشاء واتخاذ العشيقات بدلاً من تعدّد الزوجات؟ إذ إنّ عادة الزوجة الواحدة في الغرب - على حد قول
غوستاف لوبون - ليست إلاّ مادة قانونية على الورق وليس لها وجود واقعي في حياة الناس. وبقوله هو أيضاً: إنّ تعدّد الزوجات كان موجوداً في الشرق بشكل قانوني، وهذا يعني قبول الالتزام برعاية المرأة وأطفالها، وفي الغرب تجد حالة تعدّد الزوجات نفسها ولكن بشكل مخادع وغير قانوني أي بشكل اتخاذ عشيقات وخليلات، والتنصّل من الالتزام برعاية المرأة أو أبوّة الطفل.
تعدّد الزوجات في الغرب
أرى هنا أن أنقل - باختصار - شرحاً لحالة تعدّد الزوجات في الغرب في القرون الوسطى على لسان أحد المؤرّخين المحقّقين الغربيين؛ كي يعلم القرّاء المحترمون وجميع الأشخاص الذي ينتقدون الشرق بسبب تعدّد الزوجات وأحياناً بسبب مسألة الحريم، ويعتبرون ذلك ممّا يطأطئ رؤوسهم أمام الغرب، كي يعلموا جميعاً أنّ ما كان يجري في الشرق بكل نقائصه وعيوبه أفضل بألف مرّة ممّا كان يجري في الغرب في الماضي.
يعقد (ويل ديورانت) في المجلّد السابع عشر من (تاريخ الحضارة) فصلاً تحت عنوان (التفسّخ الأخلاقي) يشرح فيه الوضع الأخلاقي العام في إيطاليا في زمان الرونسانس(1) . هذا الفصل جدير بالقراءة بكل أقسامه الأحد عشر. وأنا أنقل هنا خلاصة لما جاء فيه
____________________
(1) حركة تجديدية ثقافية ظهرت في الكنيسة آنذاك.
تحت عنوان (الأخلاق الجنسية).
يبدأ ويل ديورانت هذا الفصل بمقدّمة يعتذر فيها إلى القرّاء فيقول:
(والآن إذ نأتي إلى الحديث عن أخلاق الناس غير المتدينين مبتدئين بالعلاقات الجنسية؛ يجب أن نتذكّر أولاً أنّ الرجل يميل بطبيعة إلى تعدّد الزوجات، ولا يمكن فرض نظام الزوجة الواحدة عليه إلاّ بوجود قيود أخلاقية صارمة، ودرجة معيّنة من الفقر والعمل الشاق والمراقبة الدائمة من قِبل الزوجة).
ثم يلج في صلب الموضوع فيقول:
(لا يمكن الجزم بأنّ زنا المحصنات في القرون الوسطى كان أقل ممّا في زمان الرونسانس، وكما أنّ الزنا كان يزيّن للناس في القرون الوسطى تحت غطاء الفروسية، كذلك كان يزيّن في زمان الرونسانس بين الطبقات المتعلّمة تحت عنوان الظرافة والسحر الأنثوي عند المرأة.
كانت الأسر الاصلية تحجب بناتها عن الرجال الغرباء الذين لا يمتّون إلى العائلة بصلة. وكانت مزايا العفّة قبل الزواج تُشرح لهن وتُلقّن بجد. وكان هذا التعليم مؤثّراً في بعض الأحيان إلى حد أنّه يروى أنّ شابة قد انتحرت غرقاً بسبب الاعتداء على شرفها. لكن ممّا لا شك فيه أنّ تلك الشابة كانت فريدة في نوعها؛ لذلك طلب الأساقفة أن يصنع لها تمثال بعد موتها. ويجب ملاحظة سلوك النساء قبل الزواج وإلاّ فليس بالإمكان تفسير وجود العدد الهائل من الأطفال غير الشرعيين
الذين كانت تعج بهم مدن إيطاليا. وكان الطفل غير الشرعي محروماً من جميع الامتيازات لكنّه لم يكن يحمل عاراً بنفس الدرجة. وكان الرجل إذا أراد إغراء المرأة بالزواج منه، يعدها بإيواء ولدها غير الشرعي في بيته ليعيش مع أطفاله هو. فلم يكن هذا الأمر ممّا ينقص من قدر أحد. وكانت الشرعية تكتسب بدفع رشوة إلى أحد أعضاء الكنيسة. وفي حال انعدام الأولاد الشرعيين، كان الأولاد غير الشرعيين يرثون حتى الملك والتاج. ومن هذا الطريق ورث (فرونتيه الأول) عرش (الفرنسو الاول) ملك ناپولي وصار (ليونللو دستيه) وكيلاً لنقولا الثالث أمير (فرارا).
وحين قدم (بيوس الثاني) إلى فرارا سنة 1459 كان في استقباله سبعة أُمراء كلّهم أولاد غير شرعيين، وكان التنافس بين أولاد الحرام وأولاد الحلال من ميزات الرونسانس.
أمّا فيما يتعلّق باللواط، فقد كان يفرض على الناس بدعوى إحياء العادات اليونانية القديمة... وقد لاحظ (سان برناردينو) انتشار هذا العمل في مدينة ناپولي بشكل هدّد المدينة بمصير كمصير (سدوم وعامورة)،(1) كما أنّ (آرتينو) أشاع هذا الانحراف في روما بنفس النسبة... ويمكن أن نقول نفس الشيء عن الفحشاء. واستناداً إلى رواية (اينفسورا) - الذي كان يريد أن يظهر إحصائياته بأنّها أكثر ما تكون في
____________________
(1) مدينتان على البحر الميت أمطرهما الله تعالى ناراً قصاصاً على خطايا أهلهما، المنجد، قسم الأعلام، ص 52.
روما موطن البابا - في سنة 1490 كان بين سكّان روما الذين يقدّر عددهم بتسعين ألفاً (6800) فاحشة مسجّلة في السجلات الرسمية، وهذا الرقم لا يشمل المتخفّيات أو غير المسجّلات.
وكانت في البندقية حسب إحصائية سنة 1509، (11654) فاحشة من بين سكّان المدينة البالغ عددهم ثلاثمئة ألف نسمة... وكانت البنت في القرن الخامس عشر إذا بلغت الخامسة عشرة من عمرها ولم تتزوّج بعد، تُعدّ وصمة عار على أهلها. ثم رُفعت (سن العار) في القرن السادس عشر إلى سبعة عشر عاماً من أجل فسح المجال للفتاة لتحصيل علمي أكبر. وكان الرجال بسبب تيسّر مجالات الفحشاء [ لا ] يرغبون في الزواج إلاّ إذا بذلت لهم المرأة مهراً مبالغاً فيه، وكان ينتظر أن ينمو الحب بين المرأة والرجل من خلال الحياة الزوجية المشتركة ويتقاسمان الفرح والحزن والنجاح والفشل، وهذا ما كان يحصل غالباً... ومع هذا فقد كان زنا المحصنة منتشراً كذلك. ولكون أكثر الزيجات لدى الطبقات المرفّهة كانت تتم لأغراض دبلوماسية من أجل تحقيق مصالح سياسية واقتصادية كان الرجال يرون أنّ من حقّهم اتخاذ العشيقات، فكانت الزوجة الشرعية تضطرّ إلى كظم غيظها والإغضاء عن خيانة زوجها وعدم الإشارة إليها بأيّ شكلٍ من الأشكال.
أمّا بين الطبقات الوسطى، فكان البعض من الرجال يرون في الزنا متعة مشروعة، وكان (مكيافللي) وأصحابه لا يرون بأساً في سرد
قصص خياناتهم على بعضهم. وحين كانت المرأة تقدم على الانتقام لنفسها بسبب خيانة زوجها فتخونه بدورها. كان الزوج غالباً ما يغض نظره عن عملها ويتسامح في غيرته).
كان هذا نموذجاً من حياة شعب كان يعد تعدّد الزوجات جريمة يمارسها الشرقيون، ويعزو أحياناً هذا التصرّف اللاّإنساني إلى حرارة جو الشرق، أمّا جوّهم ومناخهم فلم يكن يسمح لهم أبداً أن يخونوا نساءهم ويتجاوزوا نظام الزوجة الواحدة!!
ولابد من الإشارة إلى أنّ عدم وجود نظام تعدّد الزوجات المشروع في الغرب - بغضّ النظر عن كونه حسناً أو قبيحاً - لم يكن نتيجة لوجود الدين المسيحي. فليس في أصل الديانة المسيحية نص يحرّم تعدّد الزوجات، بل إنّ السيد المسيح لما كان قد بدأ مقرّرات التوراة - وكانت الأخيرة تجيز تعدّد الزوجات - أمكن القول إنّ تعدّد الزوجات مشروع في أصل الديانة المسيحية. وقد ذكر أنّ قدماء المسيحيين كانوا يتزوّجون من أكثر من واحدة.
إذاً فإعراض الغرب عن تعدّد الزوجات المشروع له أسباب وعلل أخرى هي:
العادة الشهرية
وعدّ آخرون العادة الشهرية للمرأة ووجوب امتناع الرجل عن مقاربتها خلال فترة العادة بالإضافة إلى تعبها من الولادة واعتزالها الحياة الزوجية واتجاهها لتغذية وتربية أطفالها، عدّوا كل ذلك سبباً
لنشوء تعدّد الزوجات.
يقول ويل ديورانت: (في المجتمعات البدائية، تهرم النساء في وقت مبكر، ولذا يعملن على تشويق أزواجهن للزواج ثانية من أجل أن يحصلن على فرصة كافية لإرضاع أطفالهن، ولكي تطول المدّة بين حمل وآخر لديهن بدون أن يعارضن رغبة الأزواج في إنجاب الأطفال أو يعارضن شهواتهم الجنسية، كما أنّ واجباتهن البيتية ستخف لوجود الزوجة الجديدة، وتحصل العائلة على أطفال جدد منها يضافون إلى ثروتها).
ممّا لا شك فيه أنّ العادة الشهرية للزوجة والإرهاق الذي يصيبها من جرّاء إنجاب الأطفال يجعل المرأة والرجل في وضع غير متساوٍ من الناحية الجنسية فيضطرّ الرجل إلى البحث عن زوجة ثانية. لكن أيّاً من العاملين المذكورين لا يكفي لوحده أن يكون سبباً في نشوء تعدّد الزوجات ما لم يتوفّر إلى جانبه مانع أخلاقي أو اجتماعي يحول بين الرجل وبين إرضاء رغباته عن طريق اتخاذ الخليلات. وإذاً فكل من العاملين المذكورين قد اقترن وجوده في وقته بوجود عوائق تمنع الرجل من الاتجاه نحو التحرّر الجنسي الكامل.
محدوديّة فترة الإخصاب عند المرأة
إنّ محدودية سن الإخصاب لدى المرأة - بخلاف الرجل - وبلوغها (سن اليأس) من عوامل نشوء تعدّد الزوجات في نظر البعض؛ إذ قد
تصل المرأة إلى هذه السن قبل أن تكون قد أنجبت عدداً كافياً من الأولاد، أو يكون الأولاد السابقون قد قضوا نحبهم. ونظراً لرغبة الرجل في الحصول على الأولاد وعدم رغبته في طلاق زوجته تراه يسعى للزواج من ثانية وثالثة، وهكذا الحال إذا كانت الزوجة عاقراً، فإنّ الرجل يتجه أيضاً إلى الزواج مجدّداً للحصول على الأطفال.
العوامل الاقتصادية
وذكرت لتعدّد الزوجات جذور اقتصادية حيث قيل إنّ الزوجة وكثرة الأولاد في الزمان القديم كانا في مصلحة الرجل، فهو يستخدم النساء والأولاد في العمل ويبيع أولاده في بعض الأحيان، كما أنّ سبب استعباد الكثير من الناس في ذلك الوقت لم يكن الوقوع في الأسر في أثناء الحروب، وإنّما كان بسبب بيع الآباء أبناءهم في أسواق النخاسة.
هذا الأمر يمكن أن يكون سبباً لنشوء تعدّد الزوجات لأنّ الرجل حين يتقبّل الزواج الرسمي سوف يحصل على مزية كثرة الأولاد ويستفيد بذلك منهم، بينما اتخاذ المرأة عشيقة وخليلة، لا يوفّر له هذه المزية. ولكن كما نعلم لا يمكن تعميم هذا السبب على أنّه علّة نشوء تعدّد الزوجات في جميع الأحوال. فإذا فرضنا أنّ تعدّد الزوجات نشأ بين الأمم البدائية لهذا السبب (لم تكن جميع الأمم على هذه الصورة) فإنّ عادة تعدّد الزوجات في الزمان القديم إنّما كانت سائدة أكثر بين الطبقات المترفة والغنيّة، وقد كان الملوك والأُمراء والقادة وعلماء
الدين وكبار التجار هم الذين ينعمون بتعدّد الزوجات، وهؤلاء بالتأكيد لم يكن غرضهم أن ينتفعوا اقتصادياً من نسائهم وأولادهم.
عامل الكثرة والعشيرة
كانت الرغبة في كثرة الأولاد وزيادة عدد نفوس الأُسرة بدورها عاملاً آخر لنشوء تعدّد الزوجات. فالذي يضع المرأة والرجل في وضع متفاوت في هذا الباب هو كون العدد الذي يمكن أن تنجبه المرأة من الأولاد محدوداً، سواء تزوّجت من واحد أو من أكثر، أمّا عدد الأولاد الذين يمكن أن ينجبهم الرجل فيعتمد على عدد النساء اللواتي يتزوّج منهن، إذ يمكن أن ينجب الرجل آلاف الأولاد لو أتيح له الاقتران بمئات النساء.
في العالم القديم - بخلاف عالم اليوم - كان عدد أفراد العشيرة يُعتبر أمراً مهمّاً من الناحية الاجتماعية. فكانت القبائل والطوائف تعمل بكل طريقة على زيادة عدد أفرادها والحيلولة دون تنقّصه. وكان ممّا يفتخر به أبناء القبائل كثرة العدد. ومن البديهي أنّ تعدّد الزوجات كان يمثّل الطريقة الوحيدة لتكثير العدد.
زيادة عدد النساء على عدد الرجال
آخر العوامل المؤثّرة في نشوء تعدّد الزوجات كان زيادة عدد النساء على عدد الرجال. وليس سبب تلك، زيادة مواليد الفتيات على مواليد الفتيان لا سابقاً ولا حاضرا، فقد تزيد مواليد الفتيات في بعض
نقاط الأرض على مواليد الفتيان وتنعكس المسألة في نقاط أخرى. لكنّ الذي يتسبّب دائماً في زيادة عدد النساء في سن الزواج على عدد الرجال في هذه السن هو أنّ وفيات الرجال تزيد دائماً على وفيات النساء، وقد كان هذا السبب ولا زال يؤدّي إلى حرمان أعداد كبيرة من النساء من الحصول على زوج شرعي وبيت وأطفال شرعيين فيما إذا التزم نظام الزوجة الواحدة.
وهذا الأمر لم يكن يسبب مشكلة في المجتمعات البدائية، فقد سبق أن نقلنا عن ويل ديورانت قوله: (في المجتمعات البدائية كانت حياة الرجل تتعرّض إلى أخطار كثيرة بسبب الحروب وممارسة الصيد ممّا يؤدّي إلى زيادة الوفيات بين الرجال عمّا هي النساء. فصارت زيادة أعداد النساء على أعداد الرجال سبباً إمّا في نشوء تعدّد الزوجات، وإمّا في حرمان عدد كبير من النساء من الأزواج).
تحقيق
كان هذا عرضاً تاريخياً لابتداء ونشوء تعدّد الزوجات والأسباب التي افترضت لذلك. لكنّنا نلاحظ أنّه قد حشرت بين هذه العلل والأسباب أمور لا تصلح أن تكون سبباً في نشوئه وذلك مثل عامل المناخ. فإذا تجاوزنا هذا العامل، واجهتنا ثلاثة عوامل ذُكرت كأسباب يمكن مناقشتها:
الأول: يمكن اعتباره سبباً غير جائز ولا شرعي ولا يمكن تفسيره إلاّ
على أساس التجنّي والظلم والاستبداد والعامل الاقتصادي الذي ذُكر سابقاً هو من هذا القبيل.
فبديهي أنّ بيع الولد هو من أكثر الأعمال التي عرفها الإنسان وحشيّة، والرغبة في تعدّد الزوجات بهذه النيّة وبهذا القصد عمل ظالم ووحشي كالعمل ذاته.
النوع الثاني من العلل والأسباب: هو ما يمكن مناقشته والنظر فيه كحق ومسوّغ للرجل أو للمجتمع من أجل قبول تعدّد الزوجات. ومثاله: عقم المرأة، أو بلوغها سن اليأس واحتياج الرجل إلى ولد، أو حاجة القبيلة أو البلاد إلى زيادة عدد النفوس. وبصورة عامة فكل العوامل التي تضع المرأة والرجل في وضع غير متساوٍ من الناحية الجنسية أو من ناحية الإنجاب تصبح مسوّغاً لتعدّد الزوجات.
وهناك نوع ثالث من العوامل والأسباب، إذا افترضنا وجوده قديماً أو حديثاً، فهو لا يُعدّ مسوّغاً للرجل أو المجتمع لتشريع تعدّد الزوجات وحسب، بل يصبح حقّاً للمرأة وواجباً على الرجل والمجتمع كي يسن هذه العادة، ألا وهو زيادة عدد النساء على عدد الرجال. فإذا فرضنا أنّه حدث في السابق أو الحاضر أن زاد عدد النساء المؤهّلات للزواج على عدد الرجال المؤهّلين له بحيث أصبح العمل بقانون الزوجة الواحدة يؤدّي إلى حرمان بعض النساء من الزواج وتشكيل أسرة خاصة بهن كباقي الناس، يصبح العمل بتعدّد الزوجات حقّاً لهؤلاء النسوة
المحرومات واجباً على الرجل تنفيذه وعلى الزوجات القبول به.
إنّ حق الزواج واحد من أهم حقوق الإنسان. ولا يجوز حرمان أحد من البشر منه بأيّة حجّة. وكل فرد له مثل هذا الحق على مجتمعه، ويجب على المجتمع أن يضع حلاًّ يتيح له الحصول عليه. وكما أنّ حق العمل وحق الطعام وحق المسك وحق التربية والتعليم وحق الحرية تعتبر حقوقاً أساسية للبشر، لا يجوز حرمانهم منها بأيّ صفةٍ وبأيّ حجّة، كذلك حق الزواج حق طبيعي لا يجوز حرمان أيّ منه. وبما أنّ العمل بقانون الزوجة الواحدة في حالة زيادة عدد النساء المؤهّلات للزواج على عدد الرجال المؤهّلين له، يحرم عدداً من النساء من هذا الحق، فإنّ هذا القانون يصبح مخالفاً للحقوق الطبيعية للإنسان.
هذا ما يتعلّق بالماضي. فماذا يجب أن يقال بالنسبة للحاضر؟ وهل أنّ العوامل المسوّغة للعمل بتعدّد الزوجات، وكذلك التي تجعل التعدّد حقّاً للمرأة؛ متوفّرةٌ في هذا الزمان أم لا؟ ولو فرضنا وجود هذه الأسباب والعوامل في الوقت الحاضر، فما الذي يمكن أن يقال عن حقوق الزوجة الأولى؟ كل هذه الأسئلة سنجيب عنها في الفصول القادمة إن شاء الله تعالى.
حق المرأة في تعدّد الزوجات (1)
فصّلنا لحدّ الآن أسباب فشل تعدّد الأزواج ونجاح تعدّد الزوجات، وأوضحنا أنّ هناك أسباباً مختلفة أدّت إلى نشوء تعدّد الزوجات منها ما كان منشؤه روح التحكّم والاستبداد لدى الرجل، ومنها ما كان ناشئاً عن التفاوت الطبيعي بين المرأة والرجل من حيث فترة الإخصاب والقابلية على إنجاب الأطفال، وهو ما يمكن اعتباره مسوّغاً للرجل للعمل بتعدّد الزوجات. أمّا العامل الرئيس الذي أوجب - طول التاريخ - تعدّد الزوجات وجعله حقّاً للمرأة واجباً على الرجل، فهو زيادة عدد النساء المهيّئات للزواج على عدد الرجال المهيّئين له.
ومن أجل أن لا نطيل الكلام، سنعرض عن الحديث عن الأسباب المسوّغة لتعدّد الزوجات ونقتصر على بحث الأمور التي إذا ما توفّرت جعلت تعدّد الزوجات حقّاً من حقوق المرأة.
ومن أجل تثبيت هذا الحق يجب أن يتحقّق أمران:
الأول: أن يثبث للإحصائيات المؤكّدة زيادة عدد النساء المهيّئات للزواج على عدد الرجال المهيّئين.
الثاني: عند تحقّق الشرط الأوّل، تصبح النساء المحرومات من الزواج ذوات حق إنساني في رقاب الرجال والنساء المتزوّجات.
أمّا فيما يخص النقطة الأُولى، فلحسن الحظ تتوفّر في هذا العصر إحصائيات دقيقة لأعداد النساء والرجل؛ ففي جميع بلدان العالم
تجري إحصائيات مستمرّة كل بضع سنوات. وفي الإحصائيات التي تتمّ بدقّة في البلدان المتقدّمة ليس فقط تظهر الأرقام الدقيقة لعدد الذكور والإناث، بل تظهر كذلك الأرقام الدقيقة لكلا الجنسين في مختلف الأعمار. فمثلاً يتبيّن من الإحصائية عدد الذكور الذين تترواح أعمارهم بين العشرين والرابعة والعشرين. وعدد الإناث اللواتي في نفس الأعمار المذكورة، وهكذا بالنسبة إلى باقي الأعمار. وقد دأبت منظمة الأمم المتحدة على نشر إحصائيات من هذا القبيل سنوياً، وقد صدر منها ستة عشر إحصائية حتى الآن، كان آخرها يرجع إلى سنة 1964م وقد نشرت في عام 1965م.
ومن الطبيعي أن نعلم أنّه لا يكفي أن نعرف عدد الذكور في بلد معيّن أو عدد الإناث فيه، إنّما المهم أن نعرف النسبة بين الرجال المؤهّلين والنساء المهيّئات للزواج؛ إذ إنّ عدد الرجال المهيّئين والنساء المهيئات للزواج غالباً ما يختلف عن مجموعهم الكلّي بصورة عامة، ولذلك سببان.
الأوّل: إنّ مرحلة البلوغ لدى الفتيات تسبق فترة البلوغ للفتيان؛ ولذا نجد سنّ الزواج القانوني للفتيات في كل قوانين العالم أقل من سن الزواج القانوني للفتيان. وبشكل عملي نجد أعمار الرجال عند الزواج تزيد - في أكثر بقاع العالم - خمس سنوات على أعمار زوجاتهم.
الثاني: وهو سبب أساس وأهم من الأوّل. وهو أنّه بالرغم من عدم
زيادة نسبة مواليد الفتيات على مواليد الفتيان في بعض أنحاء العالم، بل وتفوق عدد مواليد الفتيان على الفتيات فيها أحياناً، فإنّ الوفيات الحاصلة بين الذكور تزيد على الوفيات الحاصلة بين الإناث بحيث يختل التوازن في سن الزواج. فيزيد عدد النساء المهيّئات للزواج على عدد الرجال المهيّئين له أحياناً زيادة كبيرة؛ ولذا يمكن أن يكون عدد الذكور في بلد مساوياً لعدد الإناث بشكل عام إلاّ أنّ الأمر ينعكس بين الرجال والنساء الذين بلغوا سن الزواج.
وهذا ما نجده واضحاً في الإحصائية الأخيرة لمنظمة الأُمم المتحدة التي أجرتها عام 1964م.
ففي جمهورية كوريا(1) مثلاً، كان عدد النفوس العام طبقاً لهذه الإحصائية 635/277/26 نسمة: 289/145/13 من الذكور و346/132/13 من الإناث وفي المجموع يزيد عدد الذكور على الإناث بـ (943/12) نسمة وتبقى هذه النسبة محفوظة في الأطفال الذين هم دون السنة من العمر والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين السنة الواحدة والأربع سنوات، والذين هم بين الخامسة والتاسعة من العمر، والثانية عشرة إلى الرابعة عشرة من العمر، وأخيراً ما بين الخامسة عشرة والتاسعة عشرة من العمر. فالإحصائية تشير إلى أنّه في جميع هذه الأعمار يزيد عدد الذكور على عدد الإناث. أمّا فيما بين
____________________
(1) المقصود بها: كوريا الجنوبية وهي اليوم تزيد على (31) مليون نسمة.
العشرين والرابعة والعشرين من العمر فتنعكس النسبة إذ يبلغ مجموع عدد الذكور في هذا العمر 364/083/1 رجلاً ومجموع الإناث 051/110/1 امرأة. وابتداءً من هذه السنة فما فوق يبقى عدد النساء أكثر من عدد الرجال. هذه هي السن القانونية للزواج.
هذا مع العلم أنّ جمهورية كوريا تعيش وضعاً استثنائياً من ناحية النفوس؛ إذ يزيد عدد الذكور فيها بشكل عام على عدد الإناث، ففي الأكثرية الساحقة من بلدان العالم يزيد عدد الإناث على عدد الذكور في المجموع العام وليس فقط في عمر الزواج. ففي الاتحاد السوفيتي مثلاً يبلغ مجموع النفوس 000/101/216 نسمة، منهم 000/840/97 من الذكور و000/261/118 من الإناث، ويبقى هذا الفرق بين أعداد الجنسين ثابتاً في أعمار ما قبل الزواج وكذلك في سني الزواج، أي بين العشرين والرابعة والعشرين، وهكذا بين الخامسة والعشرين والتاسعة والعشرين، وبين الثلاثين إلى الرابعة والثلاثين، وحتى بين الثمانين والرابعة والثمانين من العمر.
وهكذا الأمر في انكلترا وفرنسا وألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية وجكوسلوفاكيا وبولندا ورومانيا والمجر والولايات المتحدة واليابان وغيرها، وهذا عدا عن كون الفرق كبيراً في بعض مناطق العالم كما في برلين الشرقية والغربية.
وفي الهند، يزيد عدد الرجال على عدد النساء حتى في عمر
الزواج. ولا يزيد عدد النساء على الرجال إلاّ في عمر الخمسين فأكثر. ويظهر أنّ سبب هذه الظاهرة هو وجود بعض العادات والخرافات القديمة التي تقضي بدفن المرأة وهي حيّة مع زوجها الميت.
في الإحصائية التي أُجريت في العام الماضي(1) في إيران، ظهر أنّ إيران من البلدان القليلة التي يزيد فيها عدد الرجال على عدد النساء. كان عدد نفوس إيران طبقاً لهذه الإحصائية 090/781/25 نسمة منهم 334/337/13 من الذكور و576/443/12 من الإناث، حيث يزيد عدد الذكور على عدد الإناث بـ 578/893 نسمة.
وأتذكّر أنّه جرى الحديث في تلك الأيام بين بعض الكتّاب حيث قالوا: انظروا كيف ثبت خطأ الداعين إلى تعدّد الزوجات إذ ظهر أنّ عدد الرجال في بلادنا يزيد على عدد النساء؛ وعليه فجيب إلغاء قانون تعدّد الزوجات.
وقد عجبت في حينه من موقف أولئك الكتّاب، فإنّهم نسوا أولاً أنّ قانون تعدّد الزوجات ليس خاصاً بإيران وثانياً إنّ المطلوب هو معرفة نسبة عدد النساء المهيّئات للزواج إلى عدد الرجال المهيّئين له وليس النسبة العامّة. وإلاّ فإنّ زيادة عدد الذكور في المجموع العام على عدد الإناث لا يعني الشيء الكبير فقد رأينا أنّ عدد الذكور في جمهورية
____________________
(1) الظاهر أنّ الإحصاء العام المشار إليه كان قد أُجري عام 1965م.
كوريا وبعض البلدان الأخرى يزيد في المجموع العام على عدد الإناث، لكنّ عدد النساء المهيّئات للزواج كان أكثر من عدد الرجال المهيّئين له، فبغض النظر عن كون الإحصائيات التي تجري في بلاد مثل إيران لا يمكن الاطمئنان إليها، فإنّنا لو أخذنا بنظر الاعتبار عقدة (ولادة الذكور) عند النساء الإيرانيات لكانت وحدها كافية للشك في هذه الإحصائية. فكلّنا نعلم أنّ المرأة الإيرانية ليست مستعدّة للظهور حتى أمام مأمور الإحصاء على أنّها منجبة للإناث أكثر من الذكور، فهي تسجّل الفتاة فتى ليفهم أنّها لا تنجب إلاّ ذكوراً. يضاف إلى هذا أنّ قانون العرض والطلب حين الزواج يؤيّد كون النساء الإيرانيات في سن الزواج أكثر عدداً من الرجال في هذه السن. ذلك أنّه بالرغم من تفشّي عادة تعدّد الزوجات في كل مكان من هذا البلد بمدنه وقراه وحتى بدوه الرحّل، إلاّ أنّ أحد لم يشعر يوماً بوجود نقص في عدد النساء المهيّئات للزواج ولم تنشأ عندنا سوق سوداء للمرأة في إيران، بل على العكس من ذلك فإنّ العرض كان ولا يزال يفوق الطلب، وأنّ الفتيات والأرامل من الشابات اللواتي يفتقرن إلى الأزواج اليوم أكثر بكثير من عدد العزّاب من الرجال، ولم يحصل في أي وقت من الأوقات أن رغب رجل - مهما كان فقيراً أو قبيح الخلقة - في الزواج وفشل في الفوز بزوجة، بينما نجد أعداداً كبيرة من النساء يعشن على كره منهن حياة العزوبة. وهذه الوقائع المشهورة والمحسوسة أصدق من كل إحصاء.
وهذا (اشلي مونتاجو) في كتابه: (المرأة: الجنس الأفضل) خلال
حديثه عن ميل المرأة إلى التزيّن والتجمّل وكونه نابعاً من عوامل اجتماعية، يعترف بهذه الحقيقة فيقول: (في جميع أنحاء المعمورة يزيد عدد النساء المهيّئات للزواج على عدد الرجال المهيّئين له.
وقد دلّت إحصائية النفوس الأمريكية لعام 1950م على وجود مليون وأربعمئة وثلاثين ألف امرأة للزواج زيادة على عدد الرجال المهيّئين له)، (مجلة امرأة اليوم العدد /69، صفحة / 71).
ويقول برتراند رسل في كتاب (الزواج والأخلاق) في الفصل المتعلّق بتعداد النفوس صفحة 115: (يوجد الآن في انكلترا أكثر من مليوني امرأة زائدة على عدد الرجال، وهؤلاء النسوة - طبقاً للعرف السائد - يجب أن يعشن إلى آخر العمر عقيمات في الواقع وهذا يشكّل حرماناً عظيماً لهن).
قرأنا في الصحف الإيرانية قبل عدّة أعوام أنّه على إثر الخسائر الكبيرة التي قدّمها الألمان في الحرب العالمية الثانية في عدد الرجال، فقد حُرمت أعداد كبيرة من النساء من الحصول على زوج قانوني وبيت، وقد ضغطت هؤلاء النسوة على الحكومة طالبات إلغاء قانون الزوجة الواحدة وإقرار قانون تعدّد الزوجات. وقد طلبت الحكومة الألمانية رسميا من الجامع الأزهر إرشاداته بهذا الخصوص، ولكنّنا علمنا بعد ذلك أنّ الكنيسة عارضت هذا الموضوع معارضة شديدة، إذ كانت تفضّل حرمان النساء من حقوقهن - أو بالأحرى تفضّل شيوع
الفحشاء - على تبنّي برنامج شرقي أو إسلامي.
سبب زيادة عدد النساء المهيّئات للزواج على عدد الرجال
ما هي علّة الأمر؟ ولماذا يزيد عدد النساء المهيّئات للزواج على عدد الرجال، بالرغم من أنّ عدد مواليد الفتيات لا يزيد على عدد مواليد الفتيان؟
علّة هذا الأمر واضحة، وهي أنّ الوفيات بين الرجال أكثر منها بين النساء. وهذه الوفيات تقع حين يكون الرجل في عمر يمكن أن يكون فيه ربّ عائلة. فلو لاحظنا الوفيات التي تحصل نتيجة الحوادث المختلفة من الحروب والغرق والموت تحت الأنقاض والاصطدامات؛ لوجدنا أنّها تصيب أكثر ما تصيب الرجال.
ومن النادر أن نجد امرأة تتعرّض لمثل هذه الحوادث، بل نجد الوفيات تحدث في صفوف الرجال سواء عند صراع الإنسان ضد الإنسان أو صراع الإنسان ضد الطبيعة. ولو أنّنا أخذنا الحرب لوحدها بنظر الاعتبار - حيث لم يمر يوم منذ بداية تاريخ الإنسان دون أن تكون فيه حرب في أكثر من بقعة من بقاع الأرض، ويقدّم فيها الرجال خسائر في الأرواح - لعلمنا لماذا يختل التوازن بين أعداد النساء والرجال في سن الزواج.
إنّ نسبة الخسائر جرّاء الحروب في عصر الماكنة أكثر بمئات الأضعاف منها في عصور الصيد والزراعة. فالخسائر التي وقعت في
الرجال خلال الحربين العالميتين - والتي قُدّرت بحوالي سبعين مليون قتيل - تساوي ما فقدته البشرية في حروبها خلال عدّة قرون سبقت. وإذا أخذتم بنظر الاعتبار الخسائر التي وقعت في الحروب التي جرت في السنين الأخيرة في الشرق الأقصى والأوسط وأفريقيا والتي ما تزال تجري، لعرفتم صدق ما قلناه في هذا الميدان.
يقول ويل ديورانت: (تدخّلت عوامل كثيرة في القضاء على هذه العادة (تعدّد الزوجات) فإنّ حياة الزراعة التي تتميّز بالاستقرار قد أدّت إلى اختصار المتاعب والمشكلات التي كانت تواجه الرجال من قبل ممّا أدى بالنتيجة إلى تساوي عدد الرجال مع عدد النساء تقريباً).
كلام (ويل ديورانت) هذا، عجيب جداً. فلو كانت الخسائر في أرواح الرجال ناتجة فقط عن الصراع مع الطبيعة، لكان هناك فرق في الخسائر بين مرحلتي الصيد والزراعة، لكن الخسائر تقع بشكل رئيس نتيجة الحروب والتي لم تكن في مرحلة الزراعة بأقل منها في مرحلة الصيد، كما أنّ الرجل كان على الدوام يقوم بحماية المرأة ويتعرّض من أجل ذلك إلى الأخطار بما في ذلك خطر الموت؛ لذا نرى أنّ اختلال التوازن بين عدد النساء وعدد الرجال كان موجوداً في مرحلة الزراعة كما هو في مرحلة الصيد. ولم يشر (ويل ديورانت) إلى عصر الصناعة من قريبٍ ولا بعيد، بينما زادت الخسائر في أرواح الرجال في هذا العصر زيادة كبيرة جدّاً، واختل التوازن بين أعداد النساء وأعداد
الرجال اختلالاً عظيماً.
المرأة أكثر مقاومة للأمراض من الرجل
وهناك حقيقة أخرى يمكن أن تُعدّ سبباً في زيادة الوفيات بين الرجال عمّا هي عليه بين النساء كشفتها أخيراً العلوم الحديثة وهي أنّ مقاومة الرجل للأمراض المختلفة أقل من مقاومة المرأة ممّا يجعل الخسائر في صفوف الرجال نتيجة الإصابة بالأمراض أكثر ممّا هي عليه في صفوف النساء.
ففي شهر دي سنة 1335 هجرية شمسية(1) كتبت صحيفة (اطلاعات) هذا الخبر: (أعلنت دائرة الإحصاءات الفرنسية أنّه بالرغم من أنّ نسبة المواليد الذكور في فرنسا تزيد على المواليد الإناث وأنّه يولد في مقابل ولادة كل مئة فتاة مئة وخمسة فتيان، ومع ذلك فإنّ عدد النساء في فرنسا يزيد على عدد الرجال بمليون وسبعمئة وخمسة وستين نسمة، وسبب ذلك أنّ مقاومة النساء للأمراض أكبر من مقاومة الرجال).
نشرت مجلة (الحديث)(2) في عددها الحادي عشر للسنة السادسة مقالاً مترجماً بقلم الدكتورة زهراء خانلري تحت عنوان (المرأة في
____________________
(1) تقابل أواخر عام 1956م أوائل عام 1957.
(2) بالفارسية: (سخن).
المجتمع والسياسة) عن مجلة اليونسكو الشهرية المصوّرة. في هذه المقالة نقل عن (اشلي مونتاغو) قوله: (إنّ المرأة بطبيعتها متفوّقة على الرجل، وكروموسوم (x) أكس الذي يتعلّق بالأُنثى أقوى من كروموسوم (y) المتعلّق بالذكر؛ لذا ترى أنّ عمر المرأة أطول من عمر الرجل، ومتوسّط عمر المرأة أطول من متوسّط عمر الرجل، والمرأة عموماً أصح جسماً من الرجل، ومقاومتها للأمراض أقوى من مقاومته. وشفاؤها حين تمرض أسرع منه، ويقابل كل امرأة لكناء خمسة رجال ذوي لكنة، ويقابل كل امرأة مصابة بعمى الألوان ستة عشر رجلاً مصاباً بعمى الألوان، وأمراض نزف الدم تنحصر تقريباً في الرجال، كما أنّ المرأة أقوى مقاومة وتماسكاً أمام الأحداث. وقد ثبت إبان الحرب الأخيرة أنّه في الأوضاع المتشابهة، كانت المرأة أكثر تحمّلاً من الرجل لمشقّة الحصار والسجن ومعسكرات الاعتقال.
... وأخيراً وليس آخراً ففي جميع البلدان تقريباً نجد أنّ حوادث الانتحار تزيد بنسبة ثلاثة أضعاف بين الرجال عنها بين النساء).
وقد ترجمت بعد ذلك، نظرية اشلي مونتاغو الخاصة بتفوّق مقاومة المرأة للأمراض، من قِبل السيد حسام الدين إمامي، ونشرت في كتاب (المرأة الجنس الأفضل) وطبعت أيضاً في مجلة امرأة اليوم، العدد (70).
ولو أنّ الرجل امتلك القدرة على الانتقام من المرأة لساقها إلى ممارسة الأعمال الخطرة والمميتة، وخصوصاً أعمال الحرب حيث
يكون جسمها الرقيق هدفاً لإطلاقات المدافع والرشّاشات والقنابل، فإنّ تفوقها في مقاومة الأمراض سيؤدّي كذلك إلى اختلال التوازن بين أعداد النساء وأعداد الرجال. كل هذا يتعلّق بالمقدّمة الأُولى، أي زيادة عدد النساء المهيّئات للزواج على عدد الرجال المهيّئين له. وقد أصبح واضحا الآن أنّ لهذا الأمر حقيقة ودافعاً، وعرف سببه كذلك. وأنّ هذا السبب كان وما يزال موجوداً منذ بدء الخليقة وحتى هذه الساعة.
حق المرأة في تعدّد الزوجات (2)
أمّا المقدّمة الثانية - أي كون تفوّق عدد النساء المهيّئات للزواج على عدد الرجال المهيّئين له، يمنح النساء حقّاً معيّناً، ويفرض على الرجال والنساء المتزوّجات واجباً فنقول فيها: أمّا كون حق الزواج من أكثر حقوق الإنسان أصالة، فأمر غني عن التعريف؛ لأنّ كلاًّ من المرأة والرجل له الحق في بناء عشّ الزوجية، والفوز بزوج وإنجاب أطفال، تماماً كما يمتلك حق العمل والمسكن والتربية والتعليم والصحّة والأمن والحرية.
وعلى المجتمع ألاّ يضع الحواجز بوجه الحصول على هذه الحقوق، بل عليه أن يؤمّن سبل تحقيقها كذلك.
في نظرنا إنّ لائحة حقوق الإنسان قد جاءت ناقصة ومن جانب مهم جداً، هو عدم تضمّنها الحق (الزواج) هذا، فإنّ هذه اللائحة قد
أشارت إلى حقوق عدّة مثل: حق الأمن والحرية، وحق التحاكم المثمر إلى المحاكم الوطنية، وحق التبعيّة وتغييرها، وحق الزواج من عنصر آخر وممّن يدين بدين آخر، وحق التملّك، وحق تشكيل الاتحادات، وحق الاستراحة، وحق التربية والتعليم. أمّا حق الزواج، أي حق تشكيل المؤسسة العائلية، فلم تشر إليه. إنّ هذا الحق لديهم أكثر ما يهم المرأة؛ لأنّها أكثر من الرجل احتياجاً إلى هذه المؤسسة. وقد ذكرنا في المقالة السابعة والعشرين أنّ الجانب المادي من الزواج هو الذي يهم الرجل أكثر، بينما تهتم المرأة بالجانب المعنوي والعاطفي فيه. فالرجل إذا فقد بيته وعائلته، يستطيع أن يوفّر نصف حاجته على الأقل عن طريق الفحشاء واتخاذ الخليلات، لكنّ أهميّة البيت والعائلة بالنسبة للمرأة تعني أكثر من ذلك، إذ لو خسرت المحيط العائلي، فلن يسد اتخاذها الخليل حاجاتها المادية ولا المعنوية.
إنّ حق الزواج بالنسبة للرجل يعني حق إشباع الغريزة الجنسية، وحق الحصول على زوج وشريك ورفيق، وحق الحصول على طفل قانوني. أمّا حق الزواج بالنسبة للمرأة فيعني بالإضافة إلى كل ذلك، حق الحصول على حامٍ ورئيس، وحق الحصول على حبيب عطوف.
والآن، وبعد إثبات المقدّمتين أي:
1 - زيادة عدد النساء على الرجال.
2 - حق الزواج حق طبيعي للإنسان.
تبيّن أنّه لو كان قانون الزوجة الواحدة هو الصورة القانونية الوحيدة للزواج، فإنّ مجاميع كبيرة من النساء سيحرمن عملياً من حق طبيعي إنساني هو حق الزواج، ولا يحيا هذا الحق إلاّ بتنفيذ قانون تعدّد الزوجات (بشروطه وحدوده بالطبع).
فعلى المثقّفات من النساء المسلمات اللواتي وجدن شخصياتهن الحقيقية بالوعي الإسلامي أن يقترحن على لجنة حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة الاعتراف بتعدّد الزوجات، في ظل الشروط المنطقية التي سنّها الإسلام، كحق من حقوق الإنسان، وأن يكون هذا الاقتراح باسم الدفاع عن الحقوق الحقيقية للمرأة وباسم الدفاع عن الأخلاق والدفاع عن الأجيال القادمة وباسم أكبر حق من حقوق الإنسان.
نظرية رسل
(برتراند رسل) نبّه - كما أشرنا سابقاً - إلى أنّه حين يكون الزواج الواحد هو الصورة القانونية الوحيدة للزواج ذلك سيؤدّي إلى حرمان أعداد كبيرة من النساء منه ولذا فهو يقترح حلاًّ. ولكن أيّ حل؟ إنّه ببساطة يقترح أن تُمنح هؤلاء النساء الحرية في اصطياد الرجال وإنجاب أطفال مجهولي الآباء كي لا يعشن الحرمان من الذرّية. ولما كانت المرأة في أثناء الحمل وبعد الوضع تحتاج إلى معونة مادّية يدفعها الأب، فيجب أن تقوم الحكومة مقام الآباء وتتكفّل دفع المعونة لمثل
هؤلاء النسوة.
يقول (رسل): (في انجلترا اليوم أكثر من مليوني امرأة أكثر من الرجال في هذه الدولة، وهؤلاء النساء يجب أن يعشن العقم بناءً على العرف السائد (عرف الزوجة الواحدة)، وهذا يشكّل بالنسبة لهنّ حرماناً عظيماً). ثم يتابع قائلاً: (إنّ نظام الزوجة الواحدة مبني على افتراض تساوي عدد النساء والرجال في البلد. فحين ينعدم التساوي، يقع ظلم عظيم على أولئك الذين يجب أن يعيشوا حالة العزوبة طبقاً لهذا القانون الرياضي. فإذا رغبنا في زيادة عدد النفوس، فإنّ الظلم سيرتفع ليس فقط في الإطار الخاص، بل في الإطار العام أيضاً).
هذا ما يقترحه أحد فلاسفة القرن العشرين حلاًّ لهذه المشكلة الاجتماعية، وهو نفس الحل الذي وضعه الإسلام لها.
الإسلام يقول: حلّوا هذه المشكلة بالطريقة الثانية، وهي أنّ يقوم الرجل الذي تتوفّر فيه مواصفات مالية وأخلاقية وبدنية معيّنة بتكفّل أكثر من امرأة، فيتخذ من المرأة الثانية زوجة قانونية وشرعية له لا يميّزها هي ولا أولادها عن زوجته الأولى وأولادها، وتتنازل الزوجة الأولى عن بعض حقّها لأُختها كواجب اجتماعي نحوها وتضحية منها لها، متقبّلة هذه الاشتراكية التي هي نوع من أكثر أنواع الاشتراكية ضرورة. بينما نجد فيلسوف القرن العشرين يقترح أن تقوم
المحرومات من النساء بسرقة أزواج النساء الأُخريات، وتتكفّل الدولة بإعالة الأطفال الذين يولدون ولا أب لهم. إنّ فيلسوف القرن العشرين هذا، يرى أنّ الزواج يجب أن يوفّر للمرأة ثلاثة أمور:
الأوّل: الجانب الجنسي، ويؤمّن هذا بذكاء المرأة وجاذبيتها.
الثاني: الأطفال، ويؤمّنون عن طريق سرقة أزواج الأُخريات.
الثالث: الجانب الاقتصادي، وهذا ما تؤمّنه الدولة في نظر هذا الفيلسوف.
إنّ الشيء الذي لا أهمّيّة له في نظر هذا الفيلسوف هو حاجة المرأة إلى العواطف الزوجية المخلصة، وحاجتها إلى أن تكون في حماية زوجها، وأن تحسّ بقربة في غير الجانب الجنسي أيضاً.
والموضوع الآخر الذي لا أهمّية له في نظر هذا الفيلسوف أيضاً هو حالة الضياع والتعاسة التي سيعيشها الطفل المولود بلا أب يرعاه؛ ذلك أنّ كل طفل بل كل إنسان محتاج إلى أن يكون ولداً لأب معروف وأمٍّ معروفة. وكل طفل محتاج إلى العواطف الصادقة لأبويه. وقد أثبتت التجارب أنّ الأم التي لا تعرف والد طفلها ولا ترتوي من حبّه، لا تستطيع أن تفيض حبّها على طفلها بصورة كافية. فمن أين يمكن تلافي هذا النقص في الحب والعطف؟ وهل يمكن للدولة أن تؤمّن ذلك؟!
ويأسف السيد رسل ألاّ يلقى اقتراحه رضا القانون فتبقى هذه
المجموعات الكبيرة من النساء عقيمة، لكنّه يعلم جيّداً أن نساء انجلترا العازبات اللائي لم يستطعن تحمّل مثل هذا القانون حللن بأنفسهن - وبشكل عملي - مشكلة العزوبة والأطفال مجهولي الأب.
من كل عشرة من الانجليز...
كتبت صحيفة (اطلاعات) بتاريخ 25/9/1338 هجري شمسي(1) تحت عنوان (من كل عشرة من الانجليز ابن حرام) تقول: (لندن - رويتر - 16 / كانون الأول - وكالة الأنباء الفرنسية: أشار التقرير الذي قدّمه الدكتور ج. أ. ت سكوت، طبيب صحة مدينة لندن إلى أنّه خلال السنة ماضية كان من بين كل عشرة مواليد طفل واحد غير شرعي. وأكّد الدكتور سكوت أنّ الولادات غير الشرعية في ازدياد مستمر، فقد زادت من 33838 ولادة في سنة 1957م لتصبح 53433 ولادة في السنة التي تلتها).
إنّ الشعب البريطاني قد حلّ مشكلته بنفسه دونما انتظار لأن يتخذ اقتراح السيد رسل صورته القانونية.
تعدّد الزوجات ممنوع واللواط مجاز
وما فعلته الحكومة البريطانية كان على خلاف رأي السيد رسل فإنّها بدلاً من أن تحل مشكلة العازبات، اعترفت بمنافسين لهن من
____________________
(1) يصادف 16/12/1959م.
جنس الرجال فزادت في حرمانهن؛ وذلك بالمصادقة على قانون (اللواط). فقد نشرت صحيفة اطلاعات بتاريخ 14/4/46(1) هجري شمسي الخبر التالي: (لندن - صادق مجلس العموم البريطاني على قانون إباحة اللواط بعد نقاش دام ثماني ساعات وسُلّم متن لائحة القانون المذكور إلى مجلس الأعيان للمصادقة النهائية عليه).
وبعد عشرة أيام، أي في 24/4/1346(2) كتبت تقول: (صادق مجلس اللوردات البريطاني في جلسته الثانية على (قانون إباحة اللواط). هذا القانون الذي سبق أن صادق عليه مجلس العموم البريطاني سرعان ما ستوقّع عليه إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا).
في الوقت الحاضر، تعدّد الزوجات ممنوع في انجلترا. أمّا اللواط فمباح في نظر هذا الشعب (الشعب الانجليزي). فإذا جاء الزوج بـ (شريكة) لزوجته من جنسها يكون قد ارتكب جريمة وعملاً غير إنساني، أمّا إذا كان الشريك من جنس الرجال، فقد قاما بعمل مشرّف وإنساني يتناسب ومقتضيات القرن العشرين. وبتعبيرٍ آخر: إنّ أهل الحل والعقد من الانجليز يرون أنّ (الشريكة) إذا كانت ذات شارب ولحية فتعدّد الزوجات في هذه الحال أمر جائز! ليسمع أولئك الذين يقولون إنّ العالم الغربي قد وجد حلاًّ لمشكلاته الجنسية والعائلية ويجب أن نفيد
____________________
(1) يصادف 5/7/1996م.
(2) يصادف 15/7/1966م.
نحن من هذا الحل، فهذا هو الحل!
إنّني لا أرى في ذلك شيئاً عجيباً، فالطريق الذي سلكه الغرب في مجال العلاقات الجنسية والعائلية لا يمكن أن يؤدّي إلى غير هذه النتائج، ولو أدّى إلى نتائج مغايرة، لكان شيئاً عجيباً.
إنّما الذي أعجب له هو لماذا فقد شعبنا منطقه؟ لماذا لا يمتلك شبابنا وخرّيجونا - هذه الأيام - القدرة على التحليل؟ لماذا فقدوا شخصيّتهم....؟ لماذا عندما تكون بين أيديهم جوهرة ويقول لهم سكّان النصف الآخر من العالم إنّ هذه جوزة، يصدّقون كلامهم ويرمون الجوهرة من أيديهم، وإذا رأوا في يد الأجنبي جوزة، وقال لهم إنّها جوهرة، صدّقوا ذلك وطافوا حولها؟!
هل طبع الرجل على تعدّد الزوجات؟
ستعجبون - ولا شك - حين تسمعون رأي الغربيين من علماء النفس وفلاسفة الاجتماع في أنّ الرجل خُلق ومن طبعه أن يعدّد الزوجات وأنّ الاقتصار على الزوجة الواحدة خلاف طبيعته.
بعد أن يتحدّث ويل ديورانت في كتابه (لذات الفلسفة) صفحة 91 عن الانحراف الخلقي اليوم في الجانب الجنسي، يقول: (ممّا لا شك فيه أنّ أكثر ذلك يعود إلى الطبع الثابت الذي نتميّز به والذي لا يرضى بغير التنوّع وعدم الاقتصار على زوجة واحدة).
وهو الذي يقول: (إنّ الرجل طبع على تعدّد الزوجات، ولا يمكن
أن يُفرض عليه نظام الزوجة الواحدة إلاّ بواسطة أقسى القيود الأخلاقية، ودرجة معيّنة من الفقر والعمل الشاق والمراقبة الدائمة من قِبل الزوجة).
كتبت مجلة (امرأة اليوم) في عددها 112 تحت عنوان: (هل الرجل خائن بالطبع؟). تقول (قال البروفيسور الألماني اشميدت:
... كان الرجل طوال التاريخ خائناً والمرأة على إثره في الخيانة، فحتى في القرون الوسطى تجد أنّ 90% من الشبّان كانوا يتبادلون الرفيقات بين الحين والآخر. و50% من المتزوّجين يخونون زوجاتهم. وكتب روبرت كينزي الباحث الأمريكي الشهير في تقريره المعروف بـ (تقرير كينزي) الشهير: إنّ الأمريكيين والأمريكيات قد فاقوا كل شعوب العالم بالخيانة... ويقول في مكان آخر من هذا التقرير: إنّ المرأة بخلاف الرجل تنفر من التلوّن والتنوّع في الحب واللذّة؛ ولذا تراها في بعض الأحيان لا تستطيع فهم تصرّفات الرجل، أمّا الرجل فيرى في التنوّع لذّة، فهو ينحرف بسهولة. والمهم عنده اللذة الحسية لا اللذة العاطفية والروحية، فلا يتظاهر بالحب العاطفي والروحي إلاّ حينما يجد فرصة للوصول إلى اللذة البدنية. وقد قال طبيب مشهور يوماً: (إنّ حب التنوّع ( Plogamy ) عند الرجل، وحب النوع الواحد ( Monogamy ) عند المرأة هو أمر بديهي؛ ذلك أنّ ملايين الحيامن تنتج من جسم الرجل بينما لا ينتج مبيضا المرأة في كل شهر أكثر من بويضة واحدة. لكن بغضّ
النظر عن فرضية كينزي، لنسأل أنفسنا هل الوفاء صعب على الرجل؟ وقد كتب (هنري دي مونترلان) الفرنسي جواباً على هذا السؤال يقول: (ليس من الصعب فقط على الرجل أن يكون وفيّاً بل من المستحيل، فإنّ امرأة واحدة قد خُلقت لرجل واحد أمّا الرجل فقد خُلق لكل الحياة ولكل النساء فإذا خان الرجل زوجته فما ذاك تقصيره هو بل تقصير الخلقة والطبع الذي أوجد فيه كل مسبّبات الخيانة)).
وفي العدد 120 كتبت المجلّة المذكورة، تحت عنوان (الحب والزواج على الطريقة الفرنسية) تقول: (إنّ الزوجين الفرنسيين قد وجدا حلاًّ لمشكلة الخيانة؛ فقد وضعا لها حدوداً وقيوداً إذا لم يتجاوزها الرجل فلا إشكال في زيغه وانحرافه ضمن هذه الحدود. فهل يمكن لرجل بعد مرور سنتين على زواجه أن يبقى وفيّاً لزوجته؟ كلاّ، بالطبع، لأنّ ذلك خلاف طبيعته. أمّا فيما يخص النساء، فالأمر يختلف نوعاً، وهنّ يدركن هذا الاختلاف، ففي فرنسا إذا ارتكب الزوج خيانة، فلا تغضب الزوجة إذ إنّها تسلّي نفسها بالقول: إنّه قد ذهب عند تلك المرأة بجسمه فقط أمّا روحه وعواطفه فهما ملك لي أنا).
ونشرت في صحيفة كيهان قبل عدّة سنوات نظرية عالم أحياء باسم الدكتور (رسل لي) تحدثت عن نفس الموضوع - وكانت مثار جدل ونقاش بين الكتّاب الإيرانيين - يرى الدكتور (رسل لي) أنّ اقتصار الرجل على امرأة واحدة خيانة للأجيال، لا من حيث الكم بل من حيث
الكيف، فإنّ اقتصاره على واحدة يضعف نسله؛ ذلك أنّ النسل لدى تعدّد الزوجات يأتي قوياً صحيح الجسم.
في رأينا إنّ هذا الوصف لطبيعة الرجل غير صحيح إطلاقاً، وإنّ رأي هؤلاء المفكّرين نابع من خصوصيات محيطهم الاجتماعي لا من حيث طبع الرجل.
نحن لا ندري - طبعاً - أنّ المرأة تماثل الرجل تماماً على ضوء علم النفس والأحياء، بل على العكس من ذلك نعتقد أنّهما يختلفان جسماً وروحاً لغرض يريده الخالق عزّ وجل؛ ولذا يجب ألاّ يتخذ من تساوي حقوق المرأة والرجل ذريعة لتماثل وتشابه الحقوق هذه. أمّا من حيث موقف المرأة والرجل من وحدة الزواج أو تعدّده فهما مختلفان، فالمرأة تميل إلى وحدة الزوج بطبعها، وتعدّد الأزواج لا ينسجم مع نفسيّتها؛ إذ إنّ ما ترغبه المرأة في الرجل لا يمكن أن يتوفّر في ظل تعدّد الأزواج. أمّا الرجل فليس من طبعه أن يحب وحدة الزوجة. بمعنى أنّ تعدّد الزوجات لا يتعارض مع طبعه ولا مع ما يحبه في المرأة.
إلاّ أنّنا نعارض الفرضية التي تقول: إنّ الزواج الواحد يتعارض مع نفسيّة الرجل، فنحن ننكر أن يكون الرجل مولعاً بالتنوّع ولعاً لا يمكن علاجه. ونختلف مع النظرة التي تقول: إنّ الوفاء صعب على الرجل وأنّ المرأة قد خُلقت لرجل واحد والرجل لكل النساء.
نحن نرى أنّ الجو الاجتماعي المنحرف هو الذي يوفّر أسباب
الخيانة لا أنّ الرجل مجبول على ذلك بالخلقة والطبيعة. إنّ المسؤول عن خيانة الرجل هو جوّه الاجتماعي لا طبعه، إنّ الذي يوفّر أسباب الخيانة هو المحيط الذي يدعو المرأة من جهة إلى كافة فنون الإغراء والغواية للرجل الأجنبي، وابتكار ألف حيلة وحيلة لحرفه وإفساده، ويحرم من جهة أخرى مئات الآلاف بل ملايين النساء المهيّئات والمحتاجات إلى الزواج من حقّهن في الزواج بحجّة أنّ الصورة القانونية الوحيدة للزواج هي وحدة الزوجة، ويدفع بهؤلاء النساء إلى المجتمع لإغواء الرجال.
وقبل رواج العادات الغربية في الشرق الإسلامي كانت نسبة الرجال الذين يقتصرون على زوجة واحدة هي 90% علماً بأن ليس لأيّ منهم أيّة عشيقة أو رفيقة أو خليلة، وكان نظام الزوجة الواحدة هو السائد من الناحية العملية في أكثر العوائل.
تعدّد الزوجات يحفظ نظام الزوجة الواحدة
ستعجبون حين أقول إنّ تعدّد الزوجات في الشرق الإسلامي هو الذي حفظ لنا نظام الزوجة الواحدة. نعم إنّ السماح بتعدّد الزوجات كان أكبر عامل في إنقاذ الزواج الواحد؛ ذلك أنّه لو لم يكن يسمح بتعدّد الزوجات عند حصول موجباته العملية ولم يكن يعطي الحق للعازبات الزائدات على عدد الرجال بالزواج من الرجال المتزوّجين الذي تتوفّر فيهم الشروط الأخلاقية والمالية والبدنية اللازمة، لأدّى وجود الخليلات والعشيقات إلى القضاء على الزواج الواحد أيضاً.
في الشرق الإسلامي، كان تعدّد الزوجات مجازاً من ناحية، ومن ناحية أخرى كانت عوامل إثارة الشهوات الجنسية مفقودة في المجتمع؛ لذا فإنّ نظام الزوجة الواحدة هو الذي كان يحكم المجتمع عملياً، ولم ينجر الرجل عن طريق اتخاذ العشيقات إلى أن يضعوا لذلك فلسفة بالتدريج، ويدّعوا أنّ الرجل قد خلق محبّاً للتعدّد والتنوّع في النساء، وأنّ الاقتصار على زوجة واحدة من المستحيلات.
يمكن أن تسألوا: إنّه إذا كان الرجل في قانون الطبيعة محبّاً للتعدّد في الزواج كما يقول هؤلاء العلماء، والقانون الاجتماعي يدين تعدّد الزوجات، فماذا سيكون موقف الرجل من هذين القانونين؟
إنّ موقف الرجل في مذهب هؤلاء السادة واضح وهو أنّ الرجل يجب أن يكون - قانوناً - ذا زوجة واحدة و - عملياً - ذا عدّة زوجات، أي: ألاّ تكون له أكثر من زوجة واحدة شرعاً وقانوناً، بينما له أن يتخذ ما شاء من العشيقات والخليلات، في نظر هؤلاء السادة، إنّ اتخاذ الرجل المعشوقات والخليلات حق طبيعي ومسلّم به ومشروع! واقتصاره طول عمره على زوجة واحدة نوع من (اللارجولة).
الوجه الحقيقي للنقاش
أرى أنّ الوقت قد حان لكي يعلم القارئ المحترم ما هي طبيعة المسألة التي عرضت للإنسان بعنوان تعدّد الزوجات؟ ماذا كانت وما هي الآن؟ ليست المسألة في أيّهما أفضل: تعدّد الزوجات أم الزوجة
الواحدة؟ إذ لاشك في أنّ الزوجة الواحدة هي الأفضل. فنظام الزوجة الواحدة يعني وحدة الأسرة، وانسجام روحين وجسمين مع بعضهما. وبديهي أنّه لما كانت الوحدة والاتحاد هما روح الحياة الزوجية، فهما في الزواج الواحد أوضح وأكمل. إنّ ما يضع الإنسان اليوم أمام مفترق الطرق ليس اختيار طريقين: وحدة الزوجة أو تعدّد الزوجات. فإنّ المطروح الآن بهذا الخصوص هو أنّه في حالة زيادة عدد النساء المؤهّلات للزواج على عدد الرجال المحتاجين له، فإنّ نظام الزوجة الواحدة نفسه يتعرّض لخطر الزوال والفناء؛ ذلك أنّ فرض نظام الزوجة الواحدة على جميع الأُسر البشرية أسطورة وأُمنية ليس إلاّ. وما على البشر إلاّ أن يختاروا أحد طريقين: إمّا الاعتراف بتعدّد الزوجات أو القبول باتخاذ العشيقات. وبتعبير آخر: إمّا القبول بتعدّد الزوجات لبعض الرجال - الذين لا تزيد نسبتهم عن العشرة بالمئة في المجتمع - وضمان حصول النساء العازبات على حياة زوجية وعائلية، وإمّا فتح الطريق أمام اتخاذ الخليلات. ويعني الاختيار الثاني - طبعاً - أنّ كل خليلة يمكن أن تتصل بأكثر من رجل، ممّا يجعل أكثر المتزوجين ذوي عدّة زوجات من الناحية العملية.
نعم هذه هي الصورة الصحيحة لعرض مسألة تعدّد الزوجات. أمّا الذين تبنّوا الدعوة لطراز الحياة الغربية فغير مستعدين لطرحها بهذه الصورة. إنّهم غير مستعدين لإعلان الحقيقة؛ لأنّهم في الواقع حماة ودعاة اتخاذ العشيقات، ولا يرون في الزوجة الشرعية والقانونية
الواحدة إلاّ عبئاً ثقيلاً عليهم وطفيلية وزائدة عن حاجاتهم، فما ظنّك بالاثنتين والثلاث والأربع.
إنّهم يجدون اللذّة في التحرّر من قيود الزواج لكنّهم يعرضون المسألة للبسطاء على أنّها دفاع عن وحدة الزواج، ويضيفون بنغمة بريئة: إنّنا نفضّل أن تكون للرجل زوجة واحدة ولا يخونها على أنّ تكون له عدّة زوجات، ويخونهن جميعاً.
مكر رجل القرن العشرين
إنّ رجل القرن العشرين قد استطاع - فيما يتعلّق بالكثير من مسائل حقوق الأُسرة - أن ينتعل النعل بالمقلوب (كما يقول المثل) وأن يخدع المرأة بكلمات معسولة وبرّاقة كالحرية والمساواة فيتخلّص من التزاماته تجاهها ويزيد في لذّاته منها. إلاّ أنّه لم ينجح في هذا الأسلوب كما نجح في أسلوب تعدّد الزوجات.
في الحقيقة إنّني أقرأ في كتابات بعض الكتّاب الإيرانيين أموراً تثير الشك عندي في أنّ ما يكتبون إمّا أن يكون عن سذاجة أو عن قصد.
كتب أحد هؤلاء الكتّاب طارحاً نظرته حول تعدّد الزوجات يقول: (في الوقت الحاضر تقوم العلاقات الزوجية في البلدان المتقدّمة على التزامات متبادلة، ولذا يعتبر الاعتراف من قِبل الزوجة بتعدّد الزوجات (دائماً كان أو منقطعاً) بنفس الدرجة من الصعوبة التي يستشعرها الرجل لو طُلب إليه القبول بوجود منافسين له على زوجته).
أنا لا أدري هل أنّ التصوّر الحقيقي لهؤلاء الأشخاص هو ما يذكرون أم أنّهم ينتعلون النعل بالمقلوب؟! أحقّاً إنّهم يجهلون أنّ تعدّد الزوجات نابع من مشكلة اجتماعية تثقل كاهل الرجل والنساء المتزوجات ولم يوجد حل لها لحد الآن أفضل من تعدّد الزوجات؟ ألا يعلمون أنّ إطباق الأجفان على العيون والهتاف (يحيا الزواج الواحد). (الموت لتعدّد الزوجات) لا يداوي جرحاً؟ ألا يعلمون أنّ تعدّد الزوجات هو من حقوق المرأة وليس من حقوق الرجل ولا علاقة له بقضيّة المساواة بين المرأة والرجل؟
مضحك قولهم: (إنّ الاعتراف بتعدّد الزوجات من قِبل الزوجة بنفس الدرجة من الصعوبة التي يستشعرها الرجل فيما لو طلب إليه أن يرضى بوجود منافسين له على زوجته). فعدا عن أنّ المقارنة مغلوطة، قد يجهل هؤلاء السادة أنّ عالم اليوم - الذي يتقبّلون كل ظاهرة جديدة باسمه دون أن يشكّوا لحظة في صحّة وسلامة ما يجري فيه - يطلب دائماً إلى الرجل أن يحترم علاقات زوجته بالرجال الآخرين، وأن يرضى بوجود منافسين له في حياته الزوجية. إنّ عالم اليوم يستنكر عدم صبر وتحمّل الزوج اشتراك الآخرين في زوجته ويصفه بأنّه حسدٌ وتعصّبٌ وغير ذلك. كم أتمنى لو أنّ شبابنا يطلعون أدنى اطلاع على ما يجري هذا اليوم في العالم الغربي في هذا الخصوص.
* * *
نظراً لأنّ تعدّد الزوجات ناشئ عن مشكلة اجتماعية لا عن طبيعة الرجل الذاتية، فبديهي أنّه في المجتمع الذي يعاني من مشكلة زيادة عدد النساء المحتاجات إلى الزواج على عدد الرجال المحتاجين إليه، سيزول تدريجياً أو يقل إلى حدٍّ كبير. وحتى إذا أردنا في مثل هذه الظروف (إذا افترضنا إمكان وجوده) أن نلغي تعدّد الزوجات كليّاً، فإنّ المنع القانوني ليس كافياً ولا صحيحاً؛ لأنّ ذلك يستدعي:
أولاً: وجود العدالة الاجتماعية وتوفّر العمل والدخل الكافي لكل رجل محتاج إلى الزواج كي يتمكّن من المبادرة إلى تشكيل عائلة.
ثانياً: حرية اختيار الفتاة للزوج الذي تريده فلا يفرض عليها أب أو أخ أن تتزوّج مكرهة من شخصٍ لغناه. وبديهي أنّ الفتاة التي تملك حرية اختيار زوجها بنفسها وتتوفّر لها فرصة الاقتران بفتى عازب لن تفكّر أبداً في الزواج من رجل متزوّج؛ ذلك أنّ أولياء الفتاة هم الذين يبيعونها - أُختاً كانت أو ابنة - إلى الأغنياء المتزوّجين.
ثالثاً: التقليل ما أمكن من عوامل الإثارة الجنسية في المجتمع وعوامل خراب البيوت وعدم تركها بالوضعية التي نراها اليوم، فإنّ عوامل الإغواء والإغراء تجتذب حتى المتزوّجة فتخرج من دار زوجها لترتمي في بيوت الأجانب فكيف بالعازبة. فإذا أراد المجتمع الحفاظ على نظام الزوجة الواحدة فعليه أن يسعى لإرساء أُسس هذه العوامل الثلاثة وإلاّ فإنّ المنع القانوني لتعدّد الزوجات سوف لن يسفر
إلاّ عن فتح باب الفحشاء على مصراعيه ليس إلاّ؟
الاختلال الناشئ عن وجود العازبات
أمّا إذا زاد عدد النساء المحتاجات للزواج على عدد الرجال المحتاجين له فإنّ منع تعدّد الزوجات خيانة للإنسانية؛ لأنّ ذلك لا يعني فقط حرمان المرأة من حقوقها. ولو اقتصر الأمر على الحرمان فقط لأمكن تحمّله، لكنّ الاضطراب الذي سيصيب المجتمع بسبب هذا الفارق هو أخطر من أيّ اضطراب آخر؛ ذلك أنّ الأُسرة هي أقدس مؤسّسة في الوجود.
إنّ الذي يحرم حقّه الطبيعي في هذه الحال هو كائن حي مع كل ردود الفعل التي يمكن أن تنشأ عن حرمان مثل هذا الكائن من حقّه. إنّ الذي أصابه الحرمان هنا، إنسان يحمل كل العقد والاضطرابات الروحية التي يفرزنا الحرمان من المسرّات، إنّه امرأة مع كل ما تحمل من مكر النساء، ابنة حواء بقدرتها الكاملة على خداع الناس.
إنّها ليست حنطة أو شعيراً يرمى في البحر إذا فاض عن الحاجة، أو يخزن في المخازن ليوم القحط... ليست داراً أو غرفة كي تقفل بابها بالأقفال إذا زادت عن الحاجة... إنّها كائن حي... إنسان... امرأة... إنّها ستستخدم قوّتها الجبّارة لتدمّر المجتمع وتدكّ أركانه، وستقول: (أقول
الحق إنّني لا استطيع أن أنظر إلى أصحابي يأكلون وأجوع)(1) . هذه الـ (لا أستطيع أن أنظر) ستظهر العجائب. إنّها ستهدم البيوت والأُسر، وتطلق العقد والأحقاد. وويل الناس حين تتحد ضدّهم الغرائز والعقد النفسية.
إنّ النساء المحرومات من تشكيل الأُسرة سيبذلن أقصى الجهود لإغواء الرجل الذي لا ترتجف أقدامه ولا تنزلق على أرض كما تنزلق وترتجف على هذه الأرض ما تحرك عليها. وبديهي أنّ (أقدام الفيلة تنزلق حين يكثر الطين) وللأسف فإنّ قليلاً من هذا (الطين) كافٍ لكي ينزلق هذا الفيل.
لكن هل يقف الأمر عند هذا الحد؟ كلاّ، بل سيأتي دور المتزوّجات. فإنّ النساء اللواتي يرين أزواجهن وهم يخونونهن؛ لابدّ أن يفكّرن في الانتقام والخيانة. إنّهن سيتابعن الرجل في الخيانة. فماذا ستكون النتيجة النهائية؟
لخّص (كنيزي روبرت) في تقريره الشهير هذه النتيجة بقوله:
(إنّ نساء أمريكا ورجالها قد فاقوا كل شعوب العالم في الخيانة وعدم الوفاء).
وتلاحظون أنّ المسألة لم تنته بفساد وانحراف الرجل وحسب، بل
____________________
(1) ترجمة بيت شعر بالفارسية هو:
(سخن درست بگويم نمى توانم ديد |
كه مي خورند حريفان ومن نظاره كنم) |
إنّ ألسنة هذا اللهب ستطول ثياب المتزوّجات وربّات البيوت في النهاية.
ردود الفعل المختلفة عند ازدياد عدد النساء
إنّ ظاهرة الزيادة النسبية لعدد النساء على الرجال كانت واضحة دائماً في حياة البشر، لكنّ الذي يتفاوت شدّة وضعفاً هو نوع ردّ الفعل الذي تولّده هذه المشكلة في المجتمع. فالشعوب التي تميل إلى العفاف والتقوى بسبب اعتناقها الأديان السماوية الكبرى قد حلّت هذه المشكلة بنظام تعدّد الزوجات. أمّا الشعوب التي لم تكن تميل إلى التديّن والعفاف فقد اتخذت ذلك ذريعةً لإشاعة الفحشاء.
فلا تعدّد الزوجات في الشرق ناشئ عن الدين الإسلامي، ولا منعه في الغرب ناشئ عن أمر الدين المسيحي؛ ذلك أنّه كان موجوداً في الشرق قبل الإسلام وقد أجازته الأديان الشرقية، كما أنّنا لا نجد نصّاً في الدين المسيحي يحرّم ذلك. أمّا موقف الغرب منه فيتعلّق بشعوب الغرب نفسها لا بالدين المسيحي.
إنّ الشعوب التي انتهجت الفحشاء طريقاً قد أضرّت بنظام الزوجة الواحدة أكثر ممّا أضرّ به تعدّد الزوجات.
يقول الدكتور محمد حسين هيكل مؤلّف كتاب (حياة محمد) بعد ذكره آيات قرآنية حول تعدّد الزوجات: (إنّ هذه الآيات ترى الاكتفاء بزوجة واحدة هو الأفضل وتقول إنّكم إذا خفتم عدم العمل بالعدل
فتزوّجوا من واحدة فقط، مؤكّدة في البين إنّكم لن تستطيعوا أن تعدلوا. ولكنّها - في نفس الوقت - بسبب إمكان نشوء ظروف اجتماعية تستوجب تعدّد الزوجات - تجيزها بشرط العدالة. إنّ محمداً (صلّى الله عليه وآله) قد اتخذ نفس هذا الموقف من أرامل شهداء الحروب الإسلامية ضدّ الكافرين فهل يمكن واقعاً أن تقولوا - بعد نشوب الحروب وحلول الأوبئة واندلاع الثورات التي يهلك خلالها الآلاف بل الملايين من الرجال، وتبقى أعداد كبيرة من النساء بلا أزواج - إنّ الاكتفاء بزوجة واحدة أفضل من تعدّد الزوجات الذي يحصل استثناءً وبشرط العدالة؟ وهل تستطيع شعوب الغرب أن تدّعي أنّ قانون الاقتصار على زوجة واحدة المسطّر على الورق فقط قد طُبّق فعلاً بعد الحرب العالمية الثانية؟).
عيوب تعدّد الزوجات
إنّ السعادة والهناء في الحياة الزوجية تكمنان في الصفاء والإخلاص... في التسامح والتضحية... في الوحدة والاتحاد بين الزوجين. وهذه كلّها تتعرّض للخطر في ظلّ تعدّد الزوجات، ففضلاً عن الظروف الشاذّة التي ستعيشها النساء والأطفال متعدّدي الأُمّهات(1) ، فإنّ الرجل الذي سيتحمّل المسؤولية الثقلية لتعدّد الزوجات إنّما يكون قد أدار ظهره للسعادة والراحة حين استقبل بوجهه تعدّد الزوجات.
____________________
(1) أي الأُم الحقيقة وزوجات الأب.
إنّ أكثر الرجال السعداء في ظل تعدّد الزوجات هم أولئك الذين تخلّوا عملياً عن مسؤولياتهم الشرعية والأخلاقية، فاهتمّوا بالزوجة الجديدة وأخرجوا القديمة من حسابهم وتركوها - كما عبّر القرآن الكريم عن ذلك بقوله -( كَالْمُعَلَّقَةِ ) . إنّ الذي يسمّيه هؤلاء الأفراد (تعدد الزوجات) ما هو في الواقع إلاّ زواج واحد مقترن بالظلم والتجنّي والاعتداء.
إنّ المثل العامي السائد بين الناس يقول: (ربٌ واحدٌ، زوجةٌ واحدةٌ)، وقد كانت هذه ولا تزال نظرة أكثر الرجال. والحقيقة أنّنا إذا أخذنا بنظر الاعتبار السعادة في الحياة الشخصية لوجدناها نظرة صحيحة. وإذا لم تصدق هذه النظرة لدى جميع الرجال، فهي تصدق لدى أكثرهم.
ولو تصوّر رجل أنّ تعدّد الزوجات بما يتضمّنه من مسؤوليات شرعية وأخلاقية هو مصدر سعادة ورفاه له، فهو واهمٌ حتماً؛ إذ ممّا لا شك فيه أنّ الزواج من واحدة يرجح على الزواج من متعدّدات في توفير الراحة والسعادة، ولكن...
الطريقة السليمة في التحقيق
ليس من الصحيح أن نقارن مسائل مثل مسألة تعدد الزوجات - بما أنّها ناشئة عن ضرورات شخصية أو اجتماعية - بنظام الزوجة الواحدة.
إنّما الطريقة الصحيحة في بحث مثل هذه المسائل هي أن نأخذ بنظر
الاعتبار أسبابها وموجباتها، وننظر في عواقب عدم الالتزام بها من جهة، ومن جهة أخرى نأخذ المفاسد والأضرار الناجمة عنها، ثم نجري محاسبة شاملة لطرفي المسألة والآثار الناتجة عنها لنخرج بنتيجة منطقية. وهذه الطريقة هي الوحيدة - في الواقع - لمعالجة مثل هذه المسائل وبحثها.
ولتوضيح الأمر نضرب المثال التالي:
لنفرض أنّنا أردنا أن نقرّر صحّة أو خطأ قانون (الخدمة الإجبارية في الجيش)، فإنّنا إذا نظرنا إليه من زاوية عائلة الشاب الذي يجب أن يلتحق بالخدمة العسكرية فقط، فلا شك أنّنا سنقرّر أنّ هذا القانون ضار، وما أحسن أن يلغى ليبقى الشاب إلى جانب أهله ولا يفارقهم قاصداً ميادين القتال حيث الحرب وسفك الدماء.
لكن بحث هذه المسألة على هذا النحو ليس صحيحاً. إنّما الصحيح أن نبحث العواقب الوخيمة التي ستتعرّض لها البلاد حين تفتقد الجنود المدافعين عنها، مع الأخذ بنظر الاعتبار ما يسبّبه فراق الجندي لأهله وحزن أهله لفراقه. لا شك أنّنا في هذه الحال سنقرّر أنّ من المنطقي والمعقول جداً أن تقوم مجموعة من شبّان الوطن - باسم الجندية - بالدفاع عن الوطن والتضحية في سبيله بأرواحهم. وأنّ على عوائلهم أن تتحمّل وتصبر على نتائج هذا العمل مهما أسفر عنه من خسائر في الأرواح والأموال.
أشرنا في المقالات السابقة إلى الضرورات الشخصية والاجتماعية التي تجوّز أحياناً تعدّد الزوجات، ونريد الآن أن نبحث عيوب تعدّد الزوجات والأضرار الناجمة عنه كي يكتمل بحث المسألة من جميع جوانبها على أساس صحيح. ويتضمّن بحث العيوب أيضاً اعترافنا بوجود مجموعة من العيوب في هذه المسألة وإن كنّا لا نقر بوجود بعض ما يذكره الآخرون كعيب لها، كما سنوضح ذلك فيما يأتي. والعيوب التي ذُكرت لتعدّد الزوجات كثيرة وسنلج البحث من عدّة نواح كما يلي:
من الناحية النفسيّة والروحيّة
العلاقة الزوجية لا تقتصر على الجوانب المالية والبدنية، ولو كان الأمر كذلك لأمكن القبول بتعدّد الزوجات بشكل عام؛ ذلك أنّ الأمور المالية والجسمية يمكن تقسيمها بين عدّة أشخاص فيأخذ كل شخص حصّته.
إنّما الأساس في العلاقة الزوجية هو الجانب الروحي والمعنوي... الحب والعطف والمشاعر، والرابط الحقيقي بين الطرفين هو القلب. والحب والمشاعر كأي شيء معنوي آخر ليسا ممّا يقبل التقسيم والتجزئة ولا يمكن توزيعهما بين أشخاص، فهل يمكن تقسيم القلب إلى نصفين، أو حضوره في مكانين في آن واحد؟ أم هل يمكن أن يوهب القلب لشخصين؟ فالحب والعبادة تفرّدٌ لا يقبلان شريكاً ولا منافساً، وليسا حنطة أو شعيراً كي يقسّم ويوزع على الأفراد. أضف إلى ذلك أنّ
المشاعر ليست ممّا يتحكّم فيه الإنسان. إذاً فالشيء الذي يمثّل روح الزواج وجانبه الإنساني، ويميز العلاقة بين إنسانين عن العلاقة بين حيوانين باعتبار الأخيرة شهوانية وغريزية صرفاً، هو شيء لا يقبل التقسيم ولا التحكّم. إذاً فتعدّد الزوجات أمر مرفوض.
في نظرنا إنّ في هذا الكلام شيئاً من المبالغة... صحيح أنّ روح الزواج هي العاطفة والمشاعر والحب، وصحيح أنّ المشاعر القلبية لا تدخل في نطاق سيطرة الإنسان ولكنّ القول بأنّ المشاعر غير قابلة للتقسيم ليس إلاّ خيال شاعر، بل مغالطة، إذ ليس الكلام في إمكانية تقسيم المشاعر بالطريقة التي تقدّ فيها قطعة لحم إلى قطعتين كي يقال إنّ الأمور الروحية لا يمكن تقسيمها. إنّما الكلام في مدى استيعاب حب شخصين؛ لأنّنا نجد أباً لعشرة أولاد، وهو يحبّهم إلى حدّ العبادة، ويضحّي من أجلهم جميعاً.
نعم، هناك شيء واحد لا يقبل الجدل أو الشك، هو أن الحب والعاطفة لا يبلغان أوجهما في حالة التعدّد كما يبلغانه في الزوجة الواحدة. فالحد الأعلى للحب والعواطف لا يتفق مع التعدّد كما لا يتفق مع العقل والمنطق كذلك.
يقول (رسل) في (الزواج والأخلاق): (يرى الكثير من الناس اليوم أنّ الحب هو تبادل منصف للمشاعر، وهذا وحده سبب كافٍ - بغض النظر عن بقيّة الأسباب - لرفض تعدد الزوجات).
أنا لا أدري لماذا يجب أن يكون التبادل المنصف للمشاعر أمراً احتكارياً، فهل إنّ حب الوالد لأولاده المتعددين ومبادلة الأولاد أباهم هذا الحب هو تبادل مشاعر غير منصف؟ ومن العجيب أنّ حب الأب لكل واحد من أولاده - رغم تعددهم - يفوق حب كل واحد منهم له.
إنّ ما أعجب له هو أن يصدر هذا الكلام عن رجل يوصي الأزواج دائماً باحترام علاقات زوجاتهم مع الغرباء وعدم الحيلولة دون قيام هذه العلاقات، كما يوصي الزوجات بمثل ذلك في المقابل. فهل يرى (رسل) أنّ تبادل العواطف بين المرأة وزوجها غير منصف هنا أيضاً؟
من الناحية التربوية
إنّ الاشتراك الزوجي هو مثالٌ لعدم الانسجام؛ إذ ليس في الوجود عدو للمرأة أخطر من (الشريكة). إنّ تعدد الزوجات يحرّض الزوجات ضد بعضهن البعض كما يحرّض الزوج على استخدام العنف ضدّهن أو ضد بعضهن، ويحوّل الجو العائلي - الذي يجب أن يكون جوّ صفاء وإخلاص - إلى ميدان حرب ونزاع وحقد وانتقام. ثم إنّ العداوة والتنافس بين الأُمّهات يسريان إلى الأولاد فينشأ عن ذلك فريقان أو أكثر يهم بعضهم ببعض فيتحول المحيط العائلي - وهو أول مدرسة ومعهد روحي للأطفال ويجب أن يكون مصدر إلهام للخير والعطف - إلى مدرسة للنفاق واللؤم.
إنّ كون تعدّد الزوجات أساساً لجميع هذه الآثار التربوية السيّئة،
أمر لا شك فيه. لكنّنا يجب أن نميّز بين الآثار الناجمة عن طبيعة تعدّد الزوجات والآثار الناجمة عن تصرّفات ومواقف الرجل وزوجته الجديدة. في نظرنا أن ليست جميع هذه المشاكل ناجمة عن طبيعة تعدّد الزوجات، بل إنّ أكثرها ناشئ عن طريقة تطبيقه.
رجل وزوجته يعيشان حياة واحدة مشتركة، وحياتهما تجري بشكل معتاد دون مشكلات، وفي هذه الأثناء يقع الزوج في شراك امرأة ثانية، وتلح على ذهنه حمّى الزواج من جديد. وبعد اتفاق سرّي، تهبط الزوجة الثانية كالأجل المعلّق لتحتل منزل وعش الزوجة الأولى وتسلبها معيشتها، وهي في الحقيقة إنّما تسطو على معيشتها وهنائها، وطبيعي أنّ ردّ الفعل النفسي للزوجة الأولى سوف لن يكون غير الحقد والانتقام إذ لا يثير غضب المرأة شيء كما يثيره احتقار زوجها إيّاها، وهي ترى أكبر هزيمة لها في الإحساس بفشلها في الاحتفاظ بقلب زوجها، والنظر إلى غيرها وهي تسلبها إيّاه. فإذا كان موقف الرجل هو العناد واتباع الهوى، وموقف الزوجة الثانية السطو والسلب، فليس من المعقول أن ننتظر من الزوجة الأولى التحمّل والصبر.
أمّا إذا كانت الزوجة الأولى تعلم أنّ لزوجها (عذراً)، ولم يكن زواجه الجديد عن ملل لها، ولا تخلٍ عنها، وإذا تخلّى الزوج عن الاستبداد والعناد ولم يتبع هواه وعاطفته، بل زاد من احترامه وإظهار عواطفه تجاه زوجته الأولى، وإذا وضعت الزوجة الجديدة نصب عينيها
أنّ للزوجة الأولى حقوقاً يجب احترامها وعدم تجاوزها، وخصوصاً أدرك الجميع أنّهم يجب أن يسهموا في حل مشكلة اجتماعية، فمّما لا شك فيه آنذاك أنّ المشكلة ستهون إلى حدٍّ كبير.
إنّ قانون تعدّد الزوجات حلٌّ راقٍ نابعٌ عن نظرة اجتماعية واسعة فيجب أن يكون منفذّوه عند المستوى الملائم لذلك وممّن تربّوا تربية إسلامية عالية.
وقد أثبتت التجربة أنّه في الحالات التي لا يمارس فيها الزوج الظلم والاستبداد ضد زوجته الأولى، ولا يريد العبث، وتشعر زوجته أنّه بحاجة إلى زوجة ثانية؛ فستتطوّع وتأتيه بها وتحتفظ بجوّ البيت بعيداً عن المشاكل؛ لأنّ أكثر هذه المشاكل إنّما تنشأ عن كيفيّة تعامل الرجال وتطبيقهم لقانون تعدد الزوجات.
من الناحية الأخلاقية
يقولون: إنّ السماح بتعدد الزوجات يعني السماح (للشره) والشهوة؛ إذ يبيح للرجل أن يعبث. بينما الأخلاق توجب على الإنسان أن يقلّل من اتباع شهواته إلى أقل حدٍّ ممكن؛ ذلك أنّ الإنسان بمقتضى طبعه، كلّما تسامح وفتح الباب على مصراعيه أمام شهواته اشتعلت نارها وطلب المزيد.
يقول مونتسكيو في (روح القوانين) صفحة 434 فيما يتعلّق بتعدّد الزوجات ما يلي:
(إنّ ملك المغرب قد جمع في دار الحريم الخاص به نساءً من كل أصل وعنصر... من البيضاء إلى الصفراء إلى السوداء. لكنّنا مع ذلك نجد أنّ هذا الرجل لو كان يملك ضعف عدد هؤلاء النساء لطلب المزيد أيضاً؛ ذلك أنّ الشهوة مثل الخسّة واللؤم كلّما تابعتها اشتدّت وقويت، وكما يؤدّي امتلاك الذهب والمال إلى ازدياد الحرص والطمع... كذلك يجر تعدّد الزوجات إلى ممارسات جنسية شاذّة (كاللواط)، ذلك أنّه في نطاق الشهوات، كلّما اندفع المرء أكثر خرج عن القاعدة. في اسطنبول، حين اشتعلت نار الثورة، وجد دار حريم أحد الحكّام خالياً من كل امرأة ذلك أنّ هذا الحاكم كان يلهو بالصبيان دون النساء).
هذا الاعتراض يجب أن يناقش من وجهين:
الوجه الأول: هو قولهم إنّ الأخلاق الفاضلة تتنافى مع أعمال الشهوة وأنّه يجب من أجل تطهير النفوس الإقلال من الشهوات.
الوجه الثاني: هو قولهم إنّ الطبيعة الإنسانية كلّما طاوعها المرء طغت به وكلّما خالفها هدأت.
أمّا الوجه الأول فيمكن أن نقول عنه أنّه - وللأسف الشديد - إيحاء مأخوذ من السلوك النصراني المبني على الرياضة الروحية، وتأثّر بالأخلاق الهندية والبوذية والكلبية. فإنّ الأخلاق الإسلامية لم تبن على هذا الأساس. فليس في الإسلام قاعدة تتضمّن أنّ الشهوات كلّما قل اتباعها، كان ذلك أكثر انسجاماً مع الأخلاق الفاضلة (وإذا بلغت
الشهوات درجة الصفر ارتفعت الأخلاق 100%) بل إنّ النظرة الأساس مبنيّة على أنّ الأخلاق إنّما تتنافى مع الإفراط في التمتّع بالشهوات.
من أجل أن نحكم هل أنّ تعدّد الزوجات هو عمل إفراطي أم لا يجب أن نحكم أولاً هل أنّ من طبع الرجل حب الزواج الواحد أم لا؟
علمنا من المقالة (31) أنّنا قد لا نجد اليوم أحداً يعتقد أنّ من طبع الرجل الاقتصار على امرأة واحدة ويرى الاتصال بعدّة نساء عملاً إفراطياً وانحرافياً، بل على العكس من ذلك فإنّ رأي أكثر الناس أنّ من طبيعة الرجل تعدّد الزوجات أو النساء، وأنّ الاقتصار على الزوجة الواحدة أو أنّ تعدد الزوجات يخالف طبيعته ويعد نوعاً من الانحراف أو الخروج على قوانين الطبيعة كاللواط.
إنّ أُناساً مثل (مونتسكيو) ممّن يرون تعدّد الزوجات عبادة للشهوة يعدّون دار الحريم انحرافاً. وقد ظنّوا أنّ الإسلام إنّما سنّ قانون تعدّد الزوجات من أجل أن يبيح للخلفاء العباسيين والعثمانيين إنشاء دور الحريم. في الوقت الذي كان الإسلام يخالف هذه الأعمال أكثر من غيره. إنّ الحدود والقيود التي وضعها الإسلام لتعدّد الزوجات تسلب الرجل العابث حرية التحرّك تماماً.
أمّا الوجه الثاني: الذي يقول: (إنّ من طبيعة الإنسان أن تطغى شهواته كلّما أُرضيت، وتخمد كلّما أُهملت) فيقابل بالضبط ما يدعو إليه أتباع (فرويد) هذه الأيام.
يقول الفرويديون: (إنّ شهوات الإنسان تهدأ على إثر الإرضاء والإشباع، وتشتد وتطغى لدى الكبت والإمساك)؛ لذا فهم يعدون مؤيّدين - مئة بالمئة - للتحرّر وخرق الآداب والسنن خاصة في المسائل الجنسية. ليت (مونتسكيو) يبعث اليوم لينظر كيف سخر الفرويديون من فرضيّته وهزئوا بها.
من وجهة نظر الأخلاق الإسلامية، كلا النظريتين خاطئتان. إنّ للطبيعة حقوقاً وحدوداً يجب معرفتها، إنّ الطبيعة تطغى وتضطرب على إثر شيئين:
الأول: الحرمان.
والثاني: إعطاء الحرية الكاملة ورفع جميع القيود والحدود من أمامها.
وعلى كل حال فلا تعدّد الزوجات خلاف الأخلاق والاستقرار الروحي والطهارة النفسية - كما يدعي أمثال (مونتسكيو) - ولا القناعة بالزوجة أو الزوجات الشرعيات ممّا يخالف الأخلاق كما يشيع الفرويديون.
من الناحية الحقوقية
بموجب عقد الزواج، يصبح كل من الزوجين ملكاً للآخر، ويملك كل منهما حق التمتّع بالآخر باعتبار أنّ منابع الزوجية قد أصبحت ملكاً لكل منهما بموجب هذا العقد. وعلى هذا الأساس تكون الزوجة السابقة صاحبة الحق رقم واحد. وكل معاملة تقع بين الزوج وامرأة ثانية تعد في الحقيقة معاملة (فضولية)؛ ذلك أنّ البضاعة - وهي هنا منافع الزوجية - قد بيعت مسبقاً للزوجة الأولى وأصبحت جزءاً من ممتلكاتها. إذاً فالتي يجب أن يؤخذ رأيها أولاً وتطلب موافقتها هي الزوجة الأُولى. فإذا أُريد السماح بتعدّد الزوجات توقّف ذلك على إذن وموافقة الزوجة الأولى. وفي الحقيقة إنّ الزوجة الأولى هي صاحبة الحق في اتخاذ القرار في أن يتزوّج من ثانية أو لا.
وعليه فإنّ الزواج من ثانية وثالثة يشبه بيع شخص ماله لآخر ثم يقوم ببيعة ثانية وثالثة ورابعة لآخرين. فصحّة هذه المعاملة تعتمد على رضا المالك الأول فالثاني فالثالث حسب الترتيب. وأمّا إذا سلّم البائع (الفضولي) المال إلى المشتري الثاني أو الثالث أو الرابع فهذا يستحقق العقاب قطعاً.
هذا الاعتراض مبني على أساس أنّ معاملة الزواج هي تبادل منفعة لا غير، وأنّ كلاًّ من الزوجين مالك للمنفعة الزوجية عند الآخر. وأنا الآن لا أبحث في هذه النقطة التي لا شك في أنّها قابلة للطعن والتفنيد.
فلنفرض أنّ الزواج قانوناً هو كذلك. فيصح هذا الاعتراض فقط حين يكون تعدّد الزوجات من قِبل الرجل بدافع طلب التنوّع والتلذّذ. وبديهي أنّ الزواج حين يكون - من الناحية القانونية - تبادل منفعة وتكون الزوجة قادرة على تأمين منافع الزواج للرجل من كل ناحية فلن يسمح للرجل بالزواج ثانية. أمّا إذا لم يكن الزواج الثاني بقصد التنوع والتلذّذ، بل كان الرجل يملك المبرّرات التي سبقت الإشارة إليها في المقالات السابقة، فلن يبقى حينها مجال لهذا الاعتراض، فمثلاً إذا كانت الزوجة عاقراً، أو يائساً، والرجل بحاجة إلى الولد، أو كانت مريضة مرضاً يمنع الاتصال الجنسي بها، في مثل هذه الحالات لن يكون من حق المرأة أن تعترض على الزواج الثاني.
هذا فقط إذا كان المسوّغ لزواجه من ثانية عذراً شخصياً، أمّا إذا كان هناك أمر يخص المجتمع ككل يقضي بتعدّد الزوجات بسبب زيادة عدد النساء على الرجال أو حاجة المجتمع إلى تكثير النفوس عند ذاك يتخذ هذا الاعتراض صورة أُخرى حيث يصبح العمل بتعدّد الزوجات تكليفاً وواجبا كفائياً، من أجل إنقاذ المجتمع من الفساد والفحشاء أو من أجل زيادة نفوس المجتمع. وبديهي أنّه حين تكون القضية قضية تكليف وواجب اجتماعي فإنّ رضا الزوجة وإجازتها يصبحان أمرين غير واردين. فإذا افترضنا أنّ المجتمع ابتُلي حقيقة بزيادة عدد النساء على الرجال أو احتاج إلى زيادة نفوسه، فإنّ واجباً كفائياً يقع على كاهل جميع الرجال والنساء المتزوّجات، ويصبح من واجب النساء أن يعملن
بمبدأ التضحية والإيثار من أجل إنقاذ المجتمع، تماماً، كواجب الدفاع عن البلد الذي يقع على كواهل جميع العوائل فيجب عليهم أن يتخلّوا عن أبنائهم من أجل المجتمع ويرسلوا بهم إلى ميادين الحرب والقتال؛ ففي مثل هذه الموارد لا تصح إجازة أو رضا الشخص أو الأشخاص ذوي العلاقة أو المنفعة.
إنّ الأشخاص الذين يدعون أنّ الحق والعدل يقضيان بأخذ إجازة الزوجة الأُولى حين تكرار الزواج، إنّما ينظرون من زاوية زواج الرجل الذي يطلب التنويع والتلذّذ ويتناسون الضرورات الفردية والاجتماعية. فحين لا تكون هناك ضرورات فردية ولا اجتماعية، فإنّ العمل بتعدّد الزوجات غير مقبول حتى لو أجازته الزوجة الأولى.
من الناحية الفلسفية
إنّ قانون تعدّد الزوجات يتنافى مع المبدأ الفلسفي القائل بتساوي حقوق المرأة والرجل على أساس تساويهما في الإنسانية. فما دام الرجل والمرأة إنسانين ومتساويين في الحقوق، فإمّا أن يجاز كلاهما للعمل بتعدّد الزوجات، أو لا يجاز. أمّا أن يجاز الرجل بالزواج من عدّة نساء في آن واحد فتفرقة وانحياز إلى جانب الرجل. إنّ السماح للرجل بالزواج من واحدة إلى أربع نساء يعني أنّ قيمة المرأة تعادل قيمة ربع رجل. وفي هذا غاية الاحتقار والإهانة للمرأة، وهو يتنافى حتى مع وجهة نظر
الإسلام الذي جعل المرأة ترث نصف ما يرث الرجل وطلب امرأتين للشهادة مقابل شهادة رجل واحد.
هذا هو أسخف اعتراض ورد على تعدّد الزوجات. إنّ المعترضين هنا لم ينظروا أبداً إلى الأسباب والموجبات الفردية ولا الاجتماعية لتعدّد الزوجات وإنّما خيّل إليهم أنّ الموضوع موضوع هوى النفس ليس إلاّ؛ لذا قالوا لماذا أُبيح الهوى للرجل ولم يبح للمرأة.
ولما كنّا قد بحثنا - فيما مضى - الأسباب والموجبات والمبرّرات التي تجوّز العمل بتعدّد الزوجات، خاصة تلك التي تجعل منه حقّاً للعازبات في ذمّة الرجال والنساء المتزوّجات، فلا داعي لبحث هذه النقطة هنا ثانية.
لكنّنا نكتفي هنا بالقول: إنّ فلسفة الإسلام حول تعدّد الزوجات والإرث والشهادة إذا كانت مبنية على إهانة المرأة والاستهانة بحقوقها وكون الإسلام يقر بوجود تفاوت بين المرأة والرجل في الإنسانية والحقوق القائمة على أساسها، إذاً لكان حكمه في جميع المواقف واحداً؛ لأنّه قائم على فلسفة واحدة. ولما قال في مكان إنّ المرأة ترث نصف ما يرث الرجل، وفي مكان آخر إنّها ترث مثل الرجل، وفي مكان ثالث إنّ للرجل أن يتزوج لحد أربع نساء وهكذا في مجال الشهادة وغير ذلك ممّا يفهم منه أن للإسلام مقاصد مختلفة أخذت بنظر الاعتبار عند إصدار الأحكام. وقد أجبنا في إحدى المقالات السابقة عن
الإشكالات التي وردت حول الإرث، قلنا في مقالة أخرى إنّ مسألة المساواة بين المرأة والرجل في الإنسانية والحقوق القائمة عليها إنّما تُعدّ في نظر الإسلام ألفباء حقوق الإنسان. وفي نظر الإسلام أنّ في مجال حقوق المرأة والرجل أموراً أعظم وأهم من التساوي ممّا يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار في المجال العملي.
نظرية الإسلام في تعدّد الزوجات
لم يكن الإسلام هو الذي ابتكر تعدّد الزوجات، فقد كان موجوداً في العالم قبل الإسلام بقرون، ولم يبطله لأنّه يرى أنّ مشكلات يمكن أن تعرض للمجتمع ينحصر حلّها في تعدّد الزوجات.
لكن الإسلام أصلح عادة تعدّد الزوجات.
التحديد
إنّ أوّل إصلاح أدخله الإسلام على هذه العادة هو تحديدها، فقد كانت غير محدودة قبل الإسلام، وكان الشخص الواحد يستطيع أن يتزوج من مئة امرأة في آن واحد ويجعل لهن دار حريم. وحين جاء الإسلام عيّن حدّاً أعلى لتعدّد الزوجات، فلم يجز لأحد أن يتزوج أكثر من أربعٍ في وقت واحد. وتروى القصص والحكايات عن أفراد عاشوا في صدر الإسلام، وكان لهم أكثر من أربع زوجات حين اعتنقوا الإسلام، فأجبرهم الدين على تسريح الزائد منهن. وقد ورد اسم غيلان بن أسلمة في جملة هؤلاء إذ كان له عشر نساء فأمره الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله)
أن يطلّق ستّاً منهن، وشخص باسم نوفل بن معاوية كان له خمسٌ، فلمّا اعتنق الإسلام أمره الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله) أن يطلّق إحداهن.
وورد في روايات الشيعة أنّ مجوسياً إيرانياً اعتنق الإسلام في زمان الإمام الصادق (عليه السلام) وكان له سبع نساء وقد سئل الإمام (عليه السلام) عن هذا الرجل، ماذا يجب أن يفعل تجاه نسائه فأجاب (عليه السلام) يجب أن يطلّق ثلاثاً منهن.
العدالة:
الإصلاح الثاني الذي أدخله الإسلام على تعدّد الزوجات هو العدالة، فلم يسمح أبداً بالتمييز بين النساء أو الأولاد. ويصرّح القرآن الكريم قائلاً: (فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة) أي إذا لم تجدوا في أنفسكم الاطمئنان الكافي لتنفيذ العدالة فاقنعوا بواحدة.
في عالم ما قبل الإسلام، لم يكن مبدأ العدالة مرعياً أصلاً، لا بين النساء ولا بين الأولاد. وقد نقلنا في المقالة 27 عن كريستينسن وغيره كيف أنّ تعدّد الزوجات كان سائداً في إيران أيام الساسانيين، وكان هناك تمييز بين النساء وكذلك بين الأولاد فكان من بين النساء مَن تدعى (الملكة) تتمتّع بحقوق كاملة بينما تدعى سائر النساء بالخادمات ويتمتعن بحقوق أقل من تلك. وأولاد الخادمات من الذكور فقط يقبلون في بيت والدهم، أمّا الفتيات فلا يقبلن.
وقد ألغى الإسلام كل هذه العادات، ولم يسمح بغمط أي حق من
حقوق المرأة أو الأولاد.
يقول ويل ديورانت في الجزء الأول من تاريخ الحضارة ضمن بحثه في تعدّد الزوجات: (كان الرجل حين تزداد ثروته ويخشى تفرّقها بعد موته بين أولاده العديدين، يحصر الإرث في أولاده من زوجته الأولى دون أولاده من خليلاته).
هذه العبارة تدل على أنّ التمييز بين النساء وبين الأولاد كان سائداً في العالم القديم. لكنّ العجب أنّ ديورانت يقول في العبارة التالية لذلك: (كان الزواج إلى زمان قريب في قارة آسيا بهذا الشكل إلى أن انحصر بزوجة واحدة تدريجياً واتخذت العلاقة بين الرجل وباقي النساء صورة العشيقات والخليلات أو انعدمت كليّاً).
إنّ ويل ديورانت نسي أو تناسى أنّ آسيا قد عاشت أربعة عشر قرناً في نور الإسلام العظيم بعيدة عن التمييز بين النساء أو الأولاد. أمّا الاحتفاظ بزوجة واحدة وعدّة خليلات فجزء من العادات الأوربية لا الآسيوية، وقد انتقلت من أوروبا إلى آسيا.
وعلى كل حال فإنّ الإصلاح الثاني الذي أدخله الإسلام على تعدّد الزوجات كان رفع التمييز بين النساء أو الأولاد.
في نظر الإسلام إنّ اتخاذ العشيقات بأيّة صورة أو شكل غير جائز، كما أنّ جميع علماء الإسلام - تقريباً - متفقون على أن التمييز بين الزوجات في المعاملة غير جائز أيضاً. لكن بعض الآراء الفقهية توجد أعذاراً
للتمييز بين بعض النساء وهي آراء نادرة، وفي نظري أنّه يجب عدم التردّد في شجبها لمخالفتها مفاهيم آيات القرآن المجيد. وقد ورد عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عن طريق الشيعة والسنّة بالاتفاق ما يفيد أنّ مَن كانت له زوجتان ولم يعدل بينهما، وأظهر الحب لإحداهما أكثر من الأخرى، حشر يوم القيامة وشق من جسمه يجر جرّاً على الأرض إلى أن ينتهي إلى جهنّم.
إنّ العدالة هي أعلى فضائل البشر، فشرط وجود العدالة يعني شرط التمتّع بأعلى الفضائل الأخلاقية. وإذا أخذنا بنظر الاعتبار أنّ عواطف الرجل تجاه نسائه لا يمكن أن تكون واحدة أو متساوية عادةً، يكون الالتزام بالعدل وتجنّب التمييز بين النساء من أصعب الواجبات.
ولكنّنا نعلم أنّ الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله) في السنوات العشر الأخيرة من عمره حين كان في المدنية وعاش مرحلة الحروب الإسلامية، وازداد في حينها عدد النساء الأرامل بين المسلمين، اختار لنفسه عدّة زوجات. كان أكثر نساء النبي (صلّى الله عليه وآله) من الأرامل والمتقدّمات في السن. وغالباً ما كان لهن من أزواجهن السابقين أولاد. والعذراء الوحيدة التي تزوّج منها النبي الأكرم (صلّى الله عليه وآله) كانت عائشة، فكانت الأخيرة تفتخر دائماً بأنّها الوحيدة من زوجات النبي (صلّى الله عليه وآله) التي لم تتزوّج بغيره (صلّى الله عليه وآله) ولم يمسّها رجل آخر.
كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يلتزم بمنتهى العدالة في التعامل مع أزواجه ولم
يميّز بينهن قط. وقد سأل عروة بن الزبير خالته عائشة عن سلوك النبي (صلّى الله عليه وآله) مع زوجاته فأجابت قائلة: كان من عادة النبي (صلّى الله عليه وآله) ألاّ يفضّل إحدانا على الأخرى، بل كان يعامل الجميع بالعدل والمساواة، وقلّما مرّ يوم لم يتفقّد فيه جميع نسائه ويسألهن عن أحوالهن، ثم ينتهي من دورته عليهن ببيت صاحبة النوبة ليبيت عندها، فإذا أراد مرة أن يبيت عند مَن لم تكن تلك الليلة نوبتها، ذهب إلى صاحبة النوبة وطلب الإذن منها للمبيت عند الأخرى فإن أذنت وإلاّ لم يذهب. أمّا أنا فلم يحدث مرة أن طلب إذني للمبيت عند أخرى فأذنت له، بل كنت دائماً لا آذن بذلك.
ولقد نفذ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) العدالة حتى خلال مرضه الذي توفّي فيه حين كان فاقد القدرة على الحركة. فمن أجل العدل ونوبة زوجاته كان يأمر كل يوم بنقل فراشه من غرفة إلى غرقة، إلى أن جمع نساءه يوماً وطلب منهن الإذن في البقاء في غرفة واحدة فأذن الجميع وبقي في غرفة عائشة.
وعلي بن أبي طالب (عليه السلام) كان - حين تكون عنده زوجتان - إذا أراد أن يتوضأ، لم يتوضأ في غرفة من لم تكن نوبتها ذلك اليوم.
إنّ الإسلام اهتم بوضع شروط العدالة موضع التنفيذ إلى درجة أنّه لم يجز للرجل والزوجة الثانية أن يشترطا حين العقد أن تكون للزوجة الجديدة حقوق أكثر من القديمة؛ وهذا يعني أنّ العمل بالعدالة في نظر الإسلام واجب لا يستطيع الرجل التهرّب من أدائه بوضع شرط في العقد
الجديد يقضي بخلاف مقتضى العدل. فلا الرجل ولا زوجته الثانية يملكان الحق في وضع مثل هذا الشرط المنافي للعدل في عقد الزواج، لكنّ الشيء الوحيد الذي تستطيع الزوجة الجديدة القيام به هو أن تتخلّى عن بعض حقوقها هي، لكن ليس لها أن تشترط أن تكون لها حقوق تفوق حقوق الزوجة الأولى، كما أنّ للزوجة الأولى الحق أيضاً في التنازل عن بعض حقوقها برضاها، لكن لا يحق لها قانوناً إن تفرض ألاّ يكون لها حقوق. وقد سُئل الإمام الباقر (عليه السلام): هل يمكن للرجل أن يضع مع زوجته شرطاً، ألا يزورها إلاّ في النهار دون الليل، أو يزورها مرة في الشهر أو الأسبوع، أو أن يشترط عدم دفع نفقة كاملة أو متساوية مع زوجته الثانية إذا رضيت بذلك؟ أجاب (عليه السلام): كلاّ، مثل هذه الشروط باطلة، وكل امرأة بموجب عقد الزواج تصبح - شاءت أم أبت - صاحبة حقوق كاملة كزوجة، إنّما الشيء الذي لها هو أنّه بعد إيقاع الزواج، يمكن للمرأة عملياً - من أجل استرجاع زوجها كي لا يتخلّى عنها، أو لأي سبب آخر - أن تتخلّى عن بعض أو جميع حقوقها.
إنّ تعدّد الزوجات مع وجود هذا الشرط الأخلاقي المؤكّد والمشدّد، سيتخذ صورة القيام بالواجب بدلاً من أن يكون وسيلة للعبث واللهو لدى الرجل. فإنّ العبث واتباع الشهوات لا ينسجم إلاّ مع الحرية المطلقة واتباع هوى القلب.
ولا يتحقق العبث واللهو إلاّ حين يضع الإنسان نفسه تحت تصرّف قلبه، ويضع قلبه تحت تصرّف هواه. والقلب وهوى القلب لا منطق لهما ولا حساب. وحين تتّخذ المسألة شكل
الانضباط والعدالة وإنجاز الواجب، يسدل الستار حينئذٍ على العبث واللهو؛ ولهذا يمكن بأيّ شكلٍ من الأشكال اعتبار تعدّد الزوجات بالشروط الإسلامية وسيلة للعبث واللهو.
والأشخاص الذين اتخذوا من تعدّد الزوجات وسيلة للهو والعبث إنّما اتخذوا القانون الإسلامي ذريعةً لعمل غير جائز، ومن حق المجتمع أن يؤاخذهم على ذلك ويعاقبهم ويكف أيديهم عنه.
الخوف من عدم العدل
من الإنصاف القول: إنّ الأفراد الذين يلتزمون بالشروط الإسلامية لتعدّد الزوجات هم قلّة قليلة. ورد في الفقه الإسلامي أنّه: (إذا خفت أن يكون استعمال الماء مضرّاً لبدنك فلا تتوضّأ). و(إذا خفت أن يضرّك الصوم فأفطر). ورد هذان الأمران في الفقه الإسلامي. وكثيراً ما نلتقي بمَن يسأل قائلاً: أخاف أن يضرّني استعمال الماء فهل أتوضأ أم لا؟... أخاف أن يضرّني الصوم، هل أصوم أم أفطر؟. وهذه أسئلة منطقية وسليمة. فمثل هؤلاء الأشخاص يجب ألاّ يتوضأوا وأن يفطروا.
ويأتي نص القرآن الكريم:( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) . ففي هذه الحالة هل سمعت في عمرك رجلاً يسأل: أريد أن أتزوّج ثانية لكنّي أخشى أن لا أعدل أو أساوي بينهما، فهل أتزوج أم لا؟ أنا لم أسمع برجل يسأل مثل هذا السؤال، كما لم تسمعه أنت حتماً. إنّ الناس عندما يرون هذا الأمر سهلاً جداً، فهم على علمهم وتصميمهم على عدم العدل،
يتزوّجون عدّة نساء، ويلقون بتبعة هذا التصرّف على الإسلام وباسم الإسلام. وهذا ما أساء إلى سمعة هذا الدين في هذا الباب.
ولو أنّ الذين يقدمون على الزواج الثاني هم فقط أُولئك الذين يتمتّعون بصفة العدالة على الأقل؛ لما كان هناك مجال للاعتراض أبداً.
بيوت الحريم
الموضوع الآخر الذي يعيبه الأجانب على النظام الإسلامي تحت اسم تعدّد الزوجات هو (بيوت الحريم) التي أنشأها الخلفاء والسلاطين سابقاً، إذ إنّ بعض الكتّاب المسيحيين يطرحون مسألة تعدّد الزوجات على أنّها مطابقة لبيوت الحريم بكل ما عرفت به من مظالم ومعايب. ويقولون: إنّ تعدّد الزوجات ليس إلاّ هذه البيوت والمنشئات التي يتحدّث عنها التاريخ.
وممّا يؤسف له: أنّ بعض كتّابنا يقلّدون الغربيين، ويردّدون كلماتهم حرفاً بحرف فيقرنون تعدّد الزوجات بدور الحريم كذلك. إنّهم فقدوا شخصياتهم واستقلالهم الفكري إلى درجة أنّهم لا يملكون أن يفرّقوا بين الاثنين.
الشروط الأخرى لتعدّد الزوجات
هناك شروط وواجبات أخرى - غير شرط العدالة - يكلّف بها الرجل كذلك، فكلّنا نعلم أنّ الزوجة في كل حال تتمتع بمجموعة من الحقوق المالية والجنسية تجاه الرجل، ولا يمكن للرجل أن يطرح
حديث الزواج الثاني ما لم تتوفّر لديه الإمكانات المالية الكافية. والحقيقة أنّ شرط التمكّن المالي يرد حتى في الزواج الأول، ولكن ليس هذا مجال تفصيل ذلك.
والإمكانات البدنية والجنسية شرط آخر وواجب ثالث يجب أن يتوفّر في الرجل ليتمكّن شرعاً من الزواج ثانية.
ورد في الكافي والوسائل عن الإمام الصادق (عليه السلام) ما يفيد، أنّ كل رجل جمع عدداً من النساء ولم يتمكّن من إرضاء غرائزهن الجنسية وسقطن في الزنا والفحشاء فإثمهن عليه. وقد جاء في قصص بيوت الحريم أنّ نساء شابات وقعن تحت ضغط الغريزة الجنسية وارتكبن الفحشاء، وأنّ ذلك كان يؤدّي أحياناً إلى وقوع القتل والجنايات.
* * *
من مجموع المقالات السبع التي مرّت حول تعدّد الزوجات؛ اطلع القارئ الكريم على جذور وأسباب وموجبات تعدّد الزوجات وعدم إلغائه من قِبَل الإسلام، وعلى الشروط والحدود والقيود التي وضعها. ووضح لديه أنّ الإسلام ما أراد بتعدّد الزوجات إهانة المرأة، بل أراد إسداء أكبر خدمة لها عن هذا الطريق. فلو أنّ تعدّد الزوجات مُنع لدى زيادة عدد النساء المهيّئات للزواج على عدد الرجال المهيّئين له - والذي كان وسيبقى ما بقيت الدنيا - لصارت المرأة لعبة - وأيّ لعبة - بيد الرجل، ولكانت معاملته لها أسوأ من معاملته للأمَة المملوكة، فإنّ الرجل
يعترف على الأقل بولده من الأمَة لكنّه لا يعترف به من الخليلة والمعشوقة.
رجل اليوم وتعدّد الزوجات
لماذا يعرض رجل اليوم عن تعدّد الزوجات؟ ألأنّه وفيٌّ لزوجته وقانع بها وحدها؟ أم لأنّه يريد أن يرضي رغبته في طلب التنويع عن طريق الحرام؟ إنّ الذي حلّ محلّ تعدّد الزوجات اليوم هو طلب الحرام لا الوفاء؛ ولذا فإنّ رجل اليوم، نافر من تعدّد الزوجات أيّما نفور؛ لأنّه يُطلب منه الالتزام والوفاء. أمّا بالنسبة لرجل الأمس فلم يكن طريق الانحراف مفتوحاً كي يعبث ويلهو بالنساء، فكان مضطرّاً يلجأ إلى تعدّد الزوجات لإرضاء غرائزه العابثة، وفي الوقت الذي كان يتنصل من القيام بكثير من واجباته في هذا السبيل، كان لا يجد مناصاً من الوفاء ببعض التعهّدات المالية والإنسانية تجاه نسائه وأولاده. أمّا رجل اليوم فلا يجد نفسه مضطرّاً إلى الالتزام بأداء أيّ واجب على طريق إرضاء نزواته وشهواته التي لا تقف عند حد؛ لذا فهو يعارض تعدّد الزوجات معارضة شديدة.
رجل اليوم يصطاد متعته من النساء تحت عنوان السكرتيرة وكاتبة الطابعة ومئات العناوين الأخرى، ويحمّل خزينة الدولة أو الشركة أو المؤسسة التي يعمل فيها ثمن هذه المتعة دون أن يدفع من جيبه ديناراً واحداً.
رجل اليوم يستبدل عشيقته كل بضعة أيام دون حاجة إلى تعقيدات المهر والنفقة والطلاق. وممّا لا شك فيه أن (موسى تشومبي) يعارض تعدّد الزوجات؛ لأنّه يجد إلى جانبه دائماً سكرتيرة شابّة حسناء يتسبدلها كل بضع سنين أو متى شاء، فما حاجته بعد ذلك إلى تعدّد الزوجات.
ونقرأ في قصّة حياة برتراند رسل - وهو من أشد مهاجمي تعدّد الزوجات - ما يلي: (في المرحلة الأولى في حياته، كانت هناك - علاوة على جدته - أُخريان كان لهما أثر مهم في حياته، إحداهما (أليس) زوجته الأولى، والأخرى رفيقته واسمها (اتولين مورل) وقد كانت (مورل) من النساء المعروفات في ذلك الزمان وكانت لها صلات حب مع الكثير من كتّاب أوائل القرن العشرين).
ممّا لا شك فيه أنّ مثل هذا الشخص لا يؤيّد تعدّد الزوجات. ويقال إنّ سلوكه ذاك في اتخاذ الخليلات هو الذي أدّى به في النهاية إلى فراق زوجته (أليس)؛ إذ كتب رسل نفسه يقول: (بعد ظهر أحد الأيام حينما كنت متجهاً على دراجتي الهوائية إلى أحد المصايف القريبة من المدينة، أحسست فجأة أنّني لم أعد أُحب (أليس)).
الفهرس
مقدّمة المؤلِّف.. 5
نظام حقوق المرأة 27
تمهيد. 27
الفصل الأوّل: طلب اليد والخطبة 35
الفصل الثاني: الزواج المؤقّت.. 45
الفصل الثالث: الاستقلال الاجتماعي للمرأة 79
الفصل الرابع: الإسلام وتجدّد الحياة 95
الفصل الخامس: القرآن ومكانة المرأة 131
الفصل السادس: الأُسرة والأُسس الطبيعية 171
الفصل السابع: فوارق المرأة والرجل. 189
الفصل الثامن: المهر والنفقة 215
الفصل التاسع: مسألة الإرث.. 267
الفصل العاشر: حق الطلاق. 277
الفصل الحادي عشر: تعدّد الزوجات.. 351
نظرية الإسلام في تعدّد الزوجات.. 435