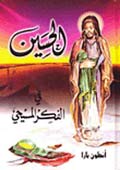الحسين (عليه السّلام) في الفكر المسيحي
الحسين (عليه السّلام) في الفكر المسيحي
جميع الحقوق محفوظة للمؤلِّف
ص. ب 26095 - الصفاة كويت
الطبعة الاُولى 1398 هـ - 1978 م - كويت
الطبعة الثانية 1400 هـ - 1980 م - كويت
طبعة مزيدة ومنقّحة
* * *
الفصل الأوّل
اسم الكتاب: الحسين (عليه السّلام) في الفكر المسيحي
المؤلّف: أنطوان بارا
عدد الصفحات: 367 صفحة
الناشر: انتشارات الهاشمي
المطبعة: نمونه
تاريخ النشر: 1984 م / 1404 هـ محرّم
حقّ الطبع محفوظ
مقدّمة الكتاب
ضمير الأديان إلى أبد الدهور
الدكتور أسعد علي
- 1 -
إنّ للألم سرّاً يتّصل بينبوع السّرور، بل يتدفّق منه كما ينشق (الأمل) من حروف (الألم) بقليل من حركيّة التركيب والتواصل بين الحروف (ألم = أمل). هذا على مستوى التركيب اللغويّ الواضح.
أمّا على مستوى الرّوح الواسع كالرّيح فظاهر المظاهر خفيّ السّرائر يكتشفه أهل الذّوق في سِير الأنبياء والشهداء والصّالحين.
- 2 -
في الإنجيل - والإنجيل يعني: البشارة - صلّى السّيد المسيح (عليه السّلام) عشيّة تسليمه، وناجى الله قائلاً: «إن كان يُستطاع فَلتعبُر عنّي هذه الكأس، لكن ليس كمشيئتي بل كمشيئتك؛ أمّا الرّوح فمستعدٌّ، وأمّا الجسد فضعيف، ولكن كيف تتمّ الكتب
فإنّه هكذا ينبغي أن يكون؟»(1) .
ضعفُ الجسد مصدر الألم، واستعداد الرّوح لتنفيذ المشيئة العليا، يصلها بينبوع السّرور الخالد.. فلا موت.. والنّصر الحقيقيّ لا يكون إلاّ انسجاماً مع التوجّه الينبوعي الطاهر.. وهل ينتصر مَن يخسر نفسه ولو ربح العالم(2) ؟
بهذا المقياس الانتصاري، ماذا يقول العالَم بثورة الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السّلام)؟ هل انسجم الحسين مع التوجّه الينبوعيّ الطّاهر، فكان منتصراً في شهادته وشهادة آل بيته؟
فطن المؤرّخون والباحثون لرمزيّة الثورة الحسينيّة، واستعذبوا تكرار السّيرة الحسينيّة؛ استلهاماً لها واستقواءً بروح صاحبها(3)
- 3 -
يقول الباحث الشابّ السيّد أنطون بارا في بحثه الجديد (الحسين في الفكر المسيحيّ) ما خلاصته: لم يسجّل التاريخ شبيهاً لاستشهاد الحسين في كربلاء، فاستشهاد الحسين وسيرته عنوان صريح لقيمة الثبات على المبدأ، ولعظمة المثاليّة في أخذ العقيدة وتمثّلها.
____________________
(1) متّي 26 / 40 - 55.
(2) المصدر نفسه 16 / 26، فإنّه ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كلّه وخسر نفسه؟
(3) يلاحظ ما كتبه عباس محمود العقّاد، والشيخ عبد الله العلايلي، والشيخ محمّد مهدي شمس الدين، وكثيرون غيرهم.
لذلك غدا حبّ الحسين الثائر واجباً علينا كبشر، وغدا حبّ الحسين الشهيد جزءاً من نفثات ضمائرنا.
فقد جاءت صيحة الحسين نبراساً لبني الإنسان في كلّ عصر ومصر، وتحت أيّة عقيدة انضوى؛ إذ إنّ أهداف الأديان هي المحبّة والتمسّك بالفضائل لتنظيم علاقة الفرد بربّه أوّلاً، وبأخيه ثانياً(1) .
إنّ بحث السيّد أنطون بارا بمجمل فصوله(2) يؤكّد حقيقة تجلّت له، وجسّدها بقوله: فقد كان الحسين (عليه السّلام) شمعة الإسلام أضاءت ممثّلة ضمير الأديان إلى أبد الدهور(3) .
إنّ هذه النتيجة مثيرة للغاية؛ لأنّها تحكم الماضي والمستقبل، ومقياس الحُكم فيها ثورة الحسين الواقعيّة.. ثمّ مثاليّة الرّمز في شخصيّته. فكيف يخرج هذا الحكم الذي يبدو وكأنّه انخطاف بالتأثّر حتّى الغلوّ؟ هل مثّل الحسين ضمير الأديان في الماضي؟ وهل يمثّله في المستقبل؟
- 4 -
ضمير الأديان بمقياس المسيحيّة وصيّتان:
____________________
(1) الحسين / 66.
(2) لاحظ عناوين الفصول: لمَن ثورة الحسين؟ ثورة الوحي الإلهي، فداء الحسين في الفكر المسيحي، معجزات الشهادة، في ضمير الإسلام، في المجتمع، في الزمن، حكمة اختلاف الشهادتين، أسباب ثورة الحسين، قريبة وبعيدة، في عهد يزيد، الخروج، آخر أقوال سيّد الشهداء ومواقفه، مقتله، الجزيرة التي أسقطت أميّة، المسيح هل تنبّأ بالحسين؟ كربلاء الأرض المقدّسة، ضمير الأديان أفضال وألقاب، سمو الشهادة في علم الجمال.
(3) الحسين / 65.
أحبب الربّ إلهك بكل قلبك وكلّ نفسك وكلّ ذهنك. هذه هي الوصيّة العظمى والاُولى.
أحبب قريبك كنفسك. هذه هي الوصيّة الثانية التي تشبه الأولى. بهاتين الوصيّتين يتعلّق الناموس كلّه والأنبياء(1)
إنّ ضمير الأديان محبّة لله وتحابّ بين العباد، كما يُفهم من عبارة السيّد المسيح، فكيف يفهم ضمير الأديان من عبارة القرآن؟
- 5 -
آيات المحبّة في القرآن الكريم تؤكّد ضمير الأديان هذا، فضمير الأديان: محبّة وتحابّ، ومن صيغ التعبير عن هذه الحقيقة: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) (2) .
قوم الله يحبّونه، وهو لذلك يحبّهم. فدينه المحبّة، ولا يقبل قوماً يرتدّون عن هذا الدين، أو يتقاعسون في تنفيذ أخلاقه التي أشارت إليها الآية: رحمة، وشدّة، وجهاداً، وشجاعة(3) .
هذا ضمير الأديان في الصّيغة الإسلاميّة، وفي الصّيغة المسيحيّة السّابقة.
____________________
(1) متّي 22 / 38 - 41.
(2) سورة المائدة / 54.
(3) تلاحظ رسالة: عبد الله خلف، حول حقيقة الحبّ في القرآن..
إنّها المحبّة والتحابّ، فكيف مثّله الحسين بن عليّ بالثورة؟
خير الأمم أمّة هَديت إلى الحقّ فَهَدت به والتزمته بالعدل(1) ، وما الحقّ الذي يجعل الاُمّة خير الاُمم؟
إنّه الإخلاص لله، والتعايش بالمعروف المطهّر من المنكر(2) .
النّصوص القرآنيّة تؤكّد مقاييس خير الاُمم بصيغة جديدة لدين الحبّ والتحابّ، فهل كانت ثورة الحسين تمثيلاً عمليّاً لضمير الأديان هذا؟
- 7 -
يقول الحسين (عليه السّلام): «إنّما خرجت لطلب الإصلاح في اُمّة جدّي، اُريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمَن قَبلني بقبول الحقّ فالله أولى بالحقّ، ومَن ردّ عليّ هذا أصبر حتّى يقضي الله بيني وبين القوم بالحقّ وهو خير الحاكمين».
حلّلت هذا النصّ مرّة أمام أصدقاء من الشّعب والعلماء في بيروت سنة 1975، وناقشنا مبادئ الأديان المركّزة فيه، إنّما جاء تركيزها ميدانيّاً، فالحسين يقرّر واقعة خروجه للثورة، ويعلن غاية ثورته طلباً للإصلاح في اُمّة
____________________
(1) لاحظ نصوص الآيات الواضحة( وممّن خلقنا أمّة يهدون بالحقّ وبه يعدلون ) (سورة الأعراف / 181).
(2)( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ) (سورة آل عمران / 110)
( وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ.... * الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ الْمُنكَرِ ) (سورة الأعراف / 156 - 157).
جدّه الذي بُعث للنّاس جميعاً، كما يعلن أصول ثورته الإصلاحيّة فهي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. حتّى يكون انسجام الإنسان مع الحقّ، فما هي دروس الثورة المعروفة في ضمير الأديان(1) والتي أوضحها الحسين بحبر جديد من دم الشهادة المحرّرة المنقذة؟
- 8 -
من دروس المعروف الخالدة في الثورة الحسينيّة: الحريّة، الإيثار، التطوّر، الإبداع.
ألا تمثّل هذه الدروس ضمير الأديان إلى أبد الدهور؟ ولكن كيف نفهمها في عصرنا كما أرادها الحسين بن علي في ثورته؟
أمثّل لذلك بمقاطع من (جامعة الحسين): أوّل دروس المعروف (الحريّة)، ويقابلها من مظاهر المنكر (العبوديّة)، فكلّ المظاهر التحكميّة أو التسلّطيّة أو الاستغلاليّة، إنّما هي مظاهر للعبودية وزبانيّة لها..
وثورة الحسين كانت وثبة شجاعة من أعماق سجون التسلّط في عصره ليخترق جدران العبوديّة مطلقاً هواء الحريّة بالفداء في فضاء الزمان؛ ليصل الهواء النقي ببعضه، من ماضٍ وحاضرٍ وآتٍ.. فالهواء حرّ من طبعه الحرّية ولا يستطيع الحياة بين جدران. الهواء الحرّ يُحيي، والهواء الحبيس يقتل.
____________________
(1) تأمّل التفاصيل في (جامعة الحسين بن علي) / 23 - 30 وقارن بالآيات المشار إليها (سورة الأعراف / 156، 157، 181)، وسورة آل عمران / 110.
حرّر الحسين، بوثبته الفدائيّة، هواء تتنفّسه النفوس الحرّة الشريفة؛ لأنّه أكّد عذوبة الموت، طلباً للإصلاح الإنسانيّ.
وإن كان الموت بهذا المستوى من العذوبة، فلماذا يستعبد الخوف الإنسان؟ لماذا لا يندفع كالسّهم الملتهب فيحترق ويخترق؟
إنّ الاحتراق الخارق حرّية فائقة المذاق. إنّه الشهادة التي تثمر الشهداء (أشهد أن لا إله إلاّ الله) عنوان جامعة الشهادة، أي الحرّية؛ لأنّ هذه العبارة تعني عدم الخضوع لغير الله والخضوع لله حرّية؛ لأنّ مَن يخضع لله يتقوّى بقوّته ويتحوّل بحوله.
والشهداء خرّيجو هذه الجامعة التي تصنع الأحرار وتدعو عشّاق الحريّة في كلّ سبيل(1) .
أمّا الدرس الثاني من دروس المعروف فهو الإيثار، ويقابل الإيثار من مظاهر المنكر الأنانيّة.
فكلّ الأعمال التي تجعل الآخرين وأشياءهم وقفاً لأنا الفرد المتسلّط، تعتبر من أشواك الأنانيّة أو من ثمارها الشائكة.
وثورة الحسين (عليه السّلام) إنّما هي خروج محبّ من أجل الجماعة، ولو كان هذا الخروج الثوريّ مودّياً بحياته وحياة أبنائه وبناته، إنّ الحسين يطلب الإصلاح في اُمّة جدّه، خير أمّة أخرجت للناس بثلاث مواقفها: الإيمان، والأمر،
____________________
(1) جامعة الحسين / 26 - 27 طبعة بيروت، 1975.
والنهي(1) ، تلك المواقف المكتوبة في التوراة والإنجيل(2) .
لقد آثر الحسين صلاح اُمّة جدّه - الإنسانيّة الهادية بالحقّ، العادلة به(3) - على حياته، فانطلق إلى كربلاء؛ ليكون عاشوراء، وليبقى الفداء ضمير الأديان المطوّر والمبدع(4) .
كذلك يفهم درس التطوّر في ثورة الحسين، وكذلك يفهم درس الإبداع فيها. وبمثل هذا الفهم يكون التحرّر من مظاهر المنكر جموداً وتخلّفاً وتقليداً أعمى.
- 9 -
أليس ضمير الأديان إيقاظاً مستمرّاً وتذكيراً دائماً بهذه المبادئ التي فداها الحسين في عاشوراء؟
أليست الحرّية والإيثار - كما فهمناهما من ثورة الحسين - جوهر وصيَّتَي الإنجيل العظميين؟
- 10 -
لقد أثار السيّد أنطون بارا في كتابه (الحسين في الفكر المسيحيّ) إثارات تدعو الإنسانيّة المعاصرة إلى مزيد من التأمّل؛ لمعرفة الحقّ الذي يحرّر كما يقول السيّد المسيح، فهل يتأمّل المعاصرون(5) ؟
____________________
(1) لاحظ نص الآية (110) من سورة آل عمران.
(2) لاحظ نص الآية (157) من سورة الأعراف.
(3) لاحظ الآية (181) من سورة الأعراف.
(4) جامعة الحسين / 27 - 28.
(5) لاحظ مثلاً كيف تنبّأ المسيح بالحسين / 295 وما بعدها. إنّ هذا يثير ما يقال: في نبوءة سليمان ومن قبله نوح، فما معنى إجماع الأنبياء على هذا؟
دمشق 21 / 5 / 1979
24 ج 2 سنة 1399 هـ
د. أسعد علي
* * *
مقدّمة الطبعة الثانية
سماحة الكاتب الإسلامي
السيّد محمّد بحر العلوم
بسم الله الرّحمن الرّحيم
أمرٌ رائع جداً أن يلتقي الفكران الإسلامي والمسيحي في قضيّة من أهمّ القضايا العقائديّة، وينتهي بهما المطاف إلى نتيجة واحدة هي الحق والعقيدة، والاستجابة لنداء الرسالة، والنضال في سبيلها بإيمان وشموخ.
فالمصدر لهذين الخطّين واحد، ومسارهما التاريخي لن يختلف، فمن الله تلك الرسالة السماويّة قد بعثت لمكارم الأخلاق تهدي الاُمّة وتنقذها من الجهالة والظلم.
فكانت رسالة المسيح (عليه السّلام)، وكانت رسالة محمد (صلّى الله عليه وآله) رسالتين هزّتا ضمير العالم، وأجّجتا فيه كلّ مشاعل الأمل، وأثّرتا فيه العطاء.
ولابدّ أن تكونا كذلك؛ لأنّهما رسالة السماء لإنقاذ البشريّة، فقد كان المجتمع في حينه ولا يزال بحاجة إلى هذا النبع الصافي لتزهر التربة بكلّ أنواع الخير: خلقاً، فضيلةً، كرامةً، وعيشاً رغيداً من أجل رفعة الإنسان وإبراز طاقاته الخلاّقة في بناء مجتمع صالح.
ولم يكن الإمام الحسين (عليه السّلام) إلاّ ذلك الامتداد الثرّ لرسالة جدّه رسول الإنسانيّة محمّد (صلّى الله عليه وآله)، ومن أجل تقويم تلك الرسالة نهض بموقفه المضحّي لتصحيح مسار الاُمّة، الذي انحرف نتيجة تحرّك الفئة الضّالة لاجتثاث تلك القيم الإنسانيّة التي جاء بها محمّد رسول الله (صلّى الله عليه وآله).
وكان تماماً ذلك الموقف الذي برز بقيادة المسيح (عليه السّلام) من قبل؛ لأجل تدعيم كلمة الحق في مجتمع تغلغل فيه الجهل، وانتشر فيه الظلام، فكان ما كان من تعنّت وتطاول على كرامة الرسالة السماويّة. فكادوا أن يغتالوا الشمس والحق، ولكنّ الله رفعه إلى سمائه حماية لإنسانه الخالد. هذا هو المسيح.
والحسين (عليه السّلام) بمسيرته الفدائيّة قد صافح السّيف، وعانق الرّماح، وأعطى القرابين تلو القرابين من أجل عقيدته، وبذلك يكون قد نال القسط الأوفر من الفداء والتضحية من يوم إسماعيل حتّى عهد المسيح؛ لذلك لم تحظِ ملحمة إنسانيّة في التاريخين القديم والحديث بمثل ما حظيت به ملحمة الاستشهاد في كربلاء من إعجاب ودرس وتعاطف. هكذا يقول الكاتب الفاضل (أنطون بارا) في كتابه (الحسين في الفكر المسيحي)، ويصفها بأنّها الاُولى والرائدة والوحيدة والخالدة في تاريخ الإنسانيّة مذ وجدت وحتّى تنقضي الدّهور، إذ هي خالدة خلود الإنسان الذي قامت من أجله.
إنّ العقيدة تصهر الإنسان لدرجة تجعله وحدة متلاحمة مع معاني الكمال والسمو، بحيث لا يمكن الفصل بينهما ولو بحدود شعرة.
وليس كبيراً على الحسين بن علي (عليه السّلام) رائد الإنسانيّة ومَثَلها الأعلى، أن يكون صاحب ثورة أُولى ورائدة ووحيدة وخالدة، بعد محمّد وعلي (عليهما الصّلاة والسّلام).
والحسين من محمّد كالرّوح من الجسد، والحسين من علي ولده الذي حمل كلّ خصائصه ومقوّماته الرائعة منذ أول يوم لامست عيناه نور الوجود، فالعقيدة مصبّ زاخر يبدأ من محمّد لعلي ثمّ الحسين، فإذا كان في هذا الامتداد، فهو من الرسالة الإسلاميّة ذلك اللبّ الأصيل، وإذا كان ذلك اللّب الرسالي الإسلامي الأصيل، فهو لا يختلف عن اللبّ الرسالي المسيحي، المسيح.
إنّها حلقة واحدة وإن تطاولت العصور، فهي من الله دعوة لهداية البشر.
ويمرّ زمان، ويأتي مَن تهمّه هذه الحقيقة ليشبك الروافد الرساليّة في مصبّ واحد. فإذا كان الاُستاذ جورج جرداق قد كتب بالأمس عن النبعة الصافية الإمام علي لعقيدة السّماء، ليؤكّد على هذا الارتباط بين المسيحيّة والإسلام، جاء اليوم الكاتب الأديب (أنطون بارا) ليمدّ الشراع ويسير نحو هذا المصبّ، ويكتب في ثورة الحسين من خلال مظلّة الفكر المسيحي، فشكراً وألف شكر لمَن يقوم بتوثيق الأواصر، وتدعيم المحبّة والاُلفة بين أنصار السّماء.
والكتاب حاز على إعجابي من خلال قراءتي له - وإن كنت أقف منه في بعض النقاط موقف الملاحظ - ولكن لا أرى المجال لذكرها؛ نظراً لعدم تأثيرها على شعوري بقيمة الكتاب اُسلوباً ومضموناً.
وأخيراً، أرجو للكاتب كلّ الخير والموفّقيّة في محاولته المبدعة، مبتهلاً إلى الله أن يدفع لنا بالنتاج تلو النتاج في هذا المضمار، وهو ولي التوفيق.
محمّد بحر العلوم - الكويت
23 / شوال - 1399 هـ - 14 / 9 / 1979 م
مقدّمة المؤلِّف
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الثورة التي فجّرها الحسين بن علي (عليه وعلى أبيه أفضل السّلام) في أعماق الصدور المؤمنة والضمائر الحرّة، هي حكاية الحريّة الموءودة بسكين الظلم في كلّ زمان ومكان، وجد بهما حاكم ظالم غشوم، لا يقيم وزناً لحريّة إنسان، ولا يصون عهداً لقضيّة بشريّة، وهي قضيّة الأحرار تحت أيّ لواء انضووا، وخلف أيّة عقيدة ساروا.
هذه الثورة التي استلهمتها عنواناً لمؤلَّفي هذا في طبعته الاُولى، كان حريّاً بها أن تظلّ هكذا عنواناً للطبعات التالية، ما دام الحديث عنها (كثورة) يعني الحديث عن شخصيّة مفجّرها (عليه السّلام)؛ إذ إنّها تمثّل خلاصات ونتائج أفكار وأفعال وتحرّكات رافع لواءها.
وبمعنى أدق هي مرآة لشخصيّته وترجمة لمبادئه ومُثُله، وأيّ تطرّقٍ لها كثورة هو تطرّقٌ لشخصيّة الحسين (عليه السّلام)، وفي المقابل فأيّ تطرّقٍ لشخصيّة الحسين هو تطرّقٌ لثورته. فتكون بذلك هذه الثورة هي الوجه الآخر لشخصيّة
صاحبها، وتكون شخصيّة صاحبها هي الوجه الآخر لها كثورة.
وقد رأى بعض المتنوّرين فكرياً بأنّ سطور الكتاب تحدّثت بإسهاب عن شخصيّة الحسين (عليه السّلام)، وحلّلت أفكاره ومبادئه وخططه وأهدافه المرحليّة الآنية منها والمستقبليّة.. فكانت الشخصيّة هي المبرّزة بما تمثّله من محصّلة المبادئ، إذ منها انطلقت الأفكار والمُثُل، وفيها اختمرت المبادئ، وفي أعماقها ربضت كلّ الموحيات التي أبرزت إلى النّور ما ظهر سواء ما كان منه قولاً أو فعلاً أو مبدأ أو ثورة، كفكرة وكفعل وكمعاناة وكهدف آني ومستقبلي، وبالتالي كخطوة لها طابع مادي بطولي يتّصل بجانبه الماديّ هذا بما تعارف عليه البشر من أفعال ماديّة بشريّة صرفة. وفي هذا علّة الثورة التي جمعت كلّ الممكنات في ثناياها،الممكنات الروحيّة، والزمنيّة، والاجتماعيّة، والماديّة البطوليّة.
لذا فمن منطلق هذه الرؤية الفكريّة لمجمل شخصيّة الحسين (عليه السّلام) تكون ثورته جزءاً من تكوّن هذه الشخصيّة، ومن ثمّ فهي مرحلة من مراحل سير مكوّناتها وتأثيراتها، بما تحمله من أفكار ومبادئ، حيث بدأت وانتهت في إحدى مراحلها، واستمرّت في سيرها خالدةً إلى أبد الدهور في مراحلها الاُخرى.
فكان حريّاً، وقد تناولنا شخصيّة الحسين بما احتوته من أفكار ومبادئ وأعمال - والثورة جزء منها - أن تكون هذه الشخصيّة هي محور البحث، وعنوان السيرة والثّوره معاً، واعتبار الثّورة جزءاً من الشخصيّة الشاملة ككل ممّا يجدر معها أن تكون الشخصيّة هي الواجهة، لا الثورة التي هي جزء من مقوّمات ومحصّلات الشخصيّة. وبالتالي يكون الحسين (عليه السّلام) كممثّل لهذه الشخصيّة ذات الخصائص والميزات القدسيّة والبشريّة الفريدة في بابها. عنوان ثورته، لا ثورته الخالدة هي عنوان شخصيّته العظيمة، ممّا يجعل من عبارة (الحسين في الفكر
المسيحي) التسمية الأكثر جدارة في هذا المعنى.
وإذا كنّيت التسمية بشخصيّة الحسين دون ثورته في الشقّ الأوّل من عنوان الكتاب، فالأحرى - كما طالَب البعض - أن تحلّ في الشقّ الثاني منه كلمة (إنساني) بدل (مسيحي) فيصبح العنوان معها (الحسين في الفكر الإنساني).
وهي فكرة صائبة، وتسمية في محلّها؛ على اعتبار أنّ ثورة سيّد الشهداء كانت ثورة إنسانيّة في مفرد ميزاتها وفي مجملها، وأخذها من وجهة نظر مسيحيّة بما يخدم البحث المقارن - الذي هو موضوع الكتاب - يصلح تقديمه كمثال على إنسانيّة هذه الثّورة، أكثر ممّا يصلح قصره على هذه الوجهة.
وبأخذنا لها من زاوية الفكر المسيحي نكون وكأنّنا ننظر إليها من زاوية الفكر الإنساني ككل؛ لأنّ الفكر المسيحي ما هو إلاّ جزء من الفكر الإنساني؛ ولأنّ المسيحية ما هي إلاّ مرحلة من مراحل المدرسة الإلهيّة التي تكوّن الدين الواحد. هذا الدين الذي جاء للبشريّة عبر مراحل متعدّدة، فكان الدواء لعلَلِها الاجتماعيّة والزمنيّة، اتّخذ عبر مراحل التاريخ منحىً متدرّجاً فكان الطابع الغالب على الرسالة (الموسويّة) طابع الإله القومي، حيث نشأت فكرة شعب الله المختار. وعلى الرسالة (العيسويّة) طابع الإله العالمي غير المتحرّر من المادّة وهذا ما تشير إليه مسألة الاُبوّة والبنوّة والتّثليث. بينما وصل الخط البياني للتوحيد في الرسالة المحمديّة إلى الذروة( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ * اللهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ) (1) .
وهكذا كان الإسلام خاتم الديانات، والرسالة المحمّديّة خاتمة النبوّات:( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلاَمَ دِيناً ) (2) . لذا
____________________
(1) سورة الإخلاص / 1 - 4.
(2) سورة المائدة / 3.
فمنطق الإيمان الكلّي بالدين الواحد يقضي بألاّ يصحّ إسلام المُسلم حتّى يتنصّرن، ولا تصحّ نصرانيّة المسيحي حتّى يتأسلم، فدين الله واحد وهدفه صناعة الإنسان.
من هذا المنطلق تكون رؤيا الفكر المسيحي لشخصيّة الحسين وثورته هي ذات رؤيا الفكر الإنساني لها، وما تحديد التسمية في عنوان الكتاب إلاّ نوع من إغناء البحث، وذلك بحصره ضمن حدود يمكن الاستشهاد بها ومقارنتها، والانطلاق منها بشكل مستوف؛ لذا فإنّ في بحث رؤيا الفكر المسيحي لثورة الحسين دلالة كافية على إنسانيّة هذه الثورة، ممّا لا يجعل بقاء الشقّ الثاني من العنوان (كما هو) أمراً يدعو إلى الدهشة؛ فالفكر المسيحي هو قاسم مشترك للفكر الإنساني، وجزء لا يتجزأ منه، يشترك معه في سداه ولحمته.
وفي تطلّعنا إلى ثورة سيّد الشهداء من كوّة هذا الفكر نكون كمَن يتطلّع إليها من كوى الفكر الإنساني كلّه؛ لأنّ هذه الثورة إنسانيةٌ أوّلاً وآخِراً؛ ولأنّ الإنسانيّة جمعاء تشترك في دين واحد يرتكز على ثوابت إلهيّة واحدة، لا تتبدّل بتبدّل الديانات، وبأساليب الإيمان بها، هذه الأساليب التي تدخل في المجال الحيوي للعقل البشري: ( شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ) (1) .
وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فإنّ أوّل ما يتبادر إلى ذهن القارئ - سواء أكان مسيحياًّ أم غير مسيحي - لدى قراءته للكتاب، هو كيف أمكن الربط بين ثورة الإمام الحسين، وبين فكر أهل الكتاب؟ إذ لم يسبق هذا الربط أي اهتمام
____________________
(1) سورة الشورى / 13.
فكري مسيحي بعَلَم من أعلام الإسلام، كي يأتي هذا الكتاب ليكمل اهتمامات سابقة بهذا الصدد.
وكان مكمن الغرابة في كون مؤلّف الكتاب الفقير لله (مسيحياً عربياً) فكانت هذه الصفة مكمناً إضافياً لجدّة البحث، ودافعاً للاطلاع عليه حتّى آخر سطرٍ منه؛ بهدف الوقوف التامّ على ما يمكن أن يضيفه هذا الفكر على ملحمة استشهاد الحسين من أبعاد جديدة.
و(الأبعاد الجديدة) في رأي البعض، هي في النظر لملحمة كربلاء من وجهة نظر مسيحيّة لكاتب ميسحي عربي، لا هو بمسلم كي يقال: بأنّه متأثّر عاطفياً بالفاجعة التي وقعت فوق ثرى الطّف، ولا هو بمستشرق صاحب فكر غربي ينظر إلى التاريخ الإسلامي نظرته إلى أيّة مرحلة تاريخيّة اُخرى، لا تخشعه هذا إلاّ الجانب التاريخي السّردي، مُهْمِلاً - عن عمدٍ أو جهلٍ - الكثير من المقوّمات الروحيّة والإلهيّة للحركة من جانبها العلوي القدسي، مجرّداً إيّاها من أهمّ ما تملك ومن أكبر أهدافها التي هدفت.
فالفكر المسيحي العربي يقدّس آل البيت (عليهم السّلام) كما المسلم، وفي أخذه لأيّة حادثة تاريخيّة تختصّ بالعالم الإسلامي الذي يعيش فيه، يهدف إلى الحيدة، مبتغياً الواقع، باحثاً عن المنطق والرؤى العقلانيّة السليمة، وهي صعوبة تتكاثف على قلم غير المسلم، الذي تحكم حيدته اعتبارات كثيرة، ولا يحتمل الزلل لأقلّ هفوة، ولا يقبل منه الشطط أو التطرّف، ولا تسمح له الأدبيات الفكريّة بإبداء ما يخالف الحقيقة، وما ينفر منه العقل الآخر الذي يخاطبه.
وفي هذا حجّة، وللحجّة سبب، بل جملة أسباب، منها أنّ الفكر المسيحي العربي يستمدّ تراثه الفكري من تراث عربي إسلامي، ويتعرّض لنفس التيّارات
الفكريّة والروحيّة التي يتعرّض لها، ويعي كلّ حادثة تاريخيّة؛ نتيجة تشرّبه لها في المدرسة، أو زيارته لأماكنها، أو لاتصال ظواهرها به. سواء في الإنسان أو الجماد أو التراث، بينما لا يملك الفكر المسيحي الغربي الخشية والإحساس الورع بقيمة الشخصيّة القدسيّة التي يتناولها، فإذا ذكر النّبي محمد لا يهمّه كثيراً وضع كلمة (صلّى الله عليه و آله) وإذا ذكر أحداً من آل البيت، لا يؤثمه عدم وضع كلمة (عليه السّلام).
هذا الفارق بين التمثّل القدسي وعدمه، فارق له أهميّته في أخذ الحادثة التاريخيّة للعالم الإسلامي، وهو فارق كبير في صغره المتناهي في ميزان النتيجة، وصغير في انعكاساته الفكريّة في ميزان الكيفيّة.
وشتّان بين كبر خطر النتيجة وبين تفاهة صغر الكيفية خلال مسار الاُمور.
هذه الغرابة، وهذا التوقّع والترقّب لِما هو محتمل في جدّته عوامل نفسيّة وفكريّة من الممكن أن تعتمل في ذهن أي قارئ حيال أثر ما يربط بين الفكر الإسلامي وبين فكر أهل الكتاب.
وبالمقابل فإنّ ما يشبهها بشكل أو بآخر يعتمل أيضاً في ذهن المفكّر المسيحي الذي يتناول فكرياً عَلَماً من أعلام الإسلام، ويدفعه للتساؤل عن مسبّبات هذه الغفلة التي يرتع فيها الفكر الإسلامي، ممّا يدمغه بصفة التقصير عن دراسة شخصيّة مثل شخصيّة الحسين، دراسة وافية منصفة، وتقديمها للعالم المسيحي الغربي والعربي، كواحدة من أنصع الصفحات بياضاً في تاريخ الإسلام.
فشخصيّة الحسين محيط واسع من المُثُل الأدبيّة والأخلاق النبويّة، وثورته فضاء واسع من المعطيات الأخلاقيّة والعقائديّة. ولعلّنا نتمثّل أهمّ سمة من سمات العظمة في هذه الشّخصيّة، من قول جدّه الرسول (صلّى الله عليه وآله): «حسين منّي وأنا من
حسين». فارتقت إنسانيّة السبط إلى حيث نبوّة الجَّد «أنا من حسين»(1) ، وهبطت نبوّة الجَّد إلى حيث إنسانيّة السبط «حسين منّي»، وفي هذا المعنى يقول السيّد الطباطبائي:
غرسٌ سقاه رسولُ الله من يدهِ |
وطاب من بعد طيبِ الأصل فارعُهُ |
وإذا كان العالم المسيحيّ الغربيّ له مآخذ على الإسلام، فإنّما ينظر إلى هذه المآخذ من كوى مثالب عهود بني اُميّة، والتشويهات التي استهدفت اُمّة الإسلام فيما بعدها، حيث نظر الحكّام إلى الدنيا والمـُلك بالشكل الذي صوّره معاوية بعد احتلاله الكوفة، إذ قال: إنّي لم اُقاتلكم لكي تصلّوا أو تصوموا، بل قاتلتكم لكي أتأمّر عليكم.
هذه النظرة المغلوطة من زاوية المادّيات الصرفة إلى أمور الدنيا وقضايا الحكم كان أبو سفيان بن حرب قد نظر من خلالها يوم فتح مكّة، إذ قال للعباس عمّ الرسول جملته الممثّلة خير تمثيل للمبدأ النفعي الذي كان مسيطراً على العقول آنذاك: لقد أصبح مُلك ابن أخيك عظيماً. فكان في قولته لا يرى من جهاد الرسول الكريم سوى ذلك المغزى الدنيوي الغلبة والعظمة، أمّا تعبيد الخلق للخالق، وتنفيذ إرادة الله في خلقه فلم تبن لناظره، ومثلُه لا يفهمها، فما يعقلها إلاّ العالمون.
هذا هو المظهر الخارجي لجوهر الصراع الذي استشرى بعد ذلك بين أهل بيت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وبين ذريّة أبي سفيان. أهل البيت (عليهم السّلام) يرون أنّ الخلافة مركب يقود
____________________
(1) انظر الإمام الحسين - الشيخ عبد الله العلايلي / 290.
إلى الآخرة وفق أحكام الله، وبنو اُميّة يتطلّعون إليها باعتبارها مركباً يقود للجاه والسّلطان، وانقياد الدنيا وفق أهواء النّفس ومطالبها. وبين أحكام الله وبين أهواء النفس حدث الانقسام المريع في جسد أمّة الإسلام، والتفّ الأبناء حول الرمز الأقرب لِما تهيّأت له أنفسهم:( مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ ) (1) .
وهكذا، فالفكر المسيحيّ الغربي لا يعي هذا التناقض الصارخ بين الحق المقهور وبين الباطل المنتصر، ومتى فَقَد هذا الوعي تجرّدت الحوادث التاريخيّة من أهمّ عناصرها؛ لذا فقد رأى المستشرقون في حادثة الطفّ - انطلاقاً من هذا التجريد - موقعة عسكريّة تغلّبت خلالها الكثرة على القلّة، والتنظيم على الارتجال، غير ملتفتين إلى اختيارات العناية الإلهيّة وسرّها وتدخّلها في هذا الحدث الجذري في المسيرة الروحيّة والتاريخيّة لاُمّة الإسلام، ولدين الله الكلّي الوحدانيّة.
من هنا يبرز دور الفكر المسيحي العربي في تمثيل الحياديّة الصرفة، محلاّ الرؤية الموضوعيّة، محلّ تلك العاطفيّة منها، والمتجنّية على السواء.
لكن هذا الدور تحكّمه حساسيّة فائقة حيال آلاف الشروحات والتفسيرات للحادثة، وكثرة الأسانيد واختلاف الروايات، وهنا مكمن الصعوبة حيث يتجلّى دور البصيرة النافذة للقيام بعمليّة غربلة حذرة لمئات من هذه الروايات، واختيار للأسانيد الموثوقة، ثمّ القيام بعمليّة تكريسيّة نهائيّة لا تقلّ صعوبة عن عمليّتي الغربلة والانتقاء، يلعب فيها الحدس والخلفيّة الثقافيّة والرؤية العقلانيّة المحايدة للكاتب أدوارها قبل أن يقرّب قلمه ويؤشّر على إحدى الروايات الأقرب إلى العقل،
____________________
(1) سورة آل عمران / 153.
والمنسجمة مع الحدث العام، والمتناغمة مع إيقاع الأحداث؛ لذا فإنّ معادلة (كل ما يقبله العقل مقبول) تظلّ رافعة أشرعتها خلال البحث ترقب تحرّكات القلم، وترصد حياديّته، بل وترغمه في أحايين كثيرة على نزع حالات شطط وتطرّف لإبراز موضوعيّة الأحداث، والحفاظ على حياديّة العمل.
وإذا كانت الحساسيّة التي تواكب قلم الكاتب غير المسلم لدى تناوله لسيرة عَلَم من أعلام الإسلام مضاعفة، فإنّها سوف تتضاعف أيضاً لدى القيام بعمليّة الربط بين المواقف المتجانسة والأهداف المشتركة بين نبيٍّ ونبي، وشهيدٍ وشهيد. سيّما إذا لم يسبق هذا الربط ربط مماثل يقرب منه أو يبعد، يشبهه أو يكاد، فتكون البداية في هذا الصدد محطّ اهتمام الكثيرين، ويكون البادئ محل هذا الاهتمام أيضاً، مضافاً إليه النقد والاستحسان أو الاستهجان.
ولعلّ هذا المؤلّف لم يسلم من هذا النقد، كما لم يحرم من هذا الاستهجان والاستحسان، شأن، شأن أي عمل طابعه الجدّة. ولكن العامل المتّكل على الله في عمله، لا يعدم الإحساس بالرضا عن عمله مهما قوبل بالنقد، إيجابياً كان أم سلبياً:( وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ) (1) .
أسوق هذه التهيئة البسيطة في متن هذه المقدّمة للكتاب، والتي لا يصحّ سَوق مثلها في المتن بعد تجاوز بداية المقال، لأصِلَ إلى مدخل الفصل الأهمّ من الكتاب، والذي يمثّل (الحسّاسيّة) التي عنيتها تواكب قلم الكاتب، فأشير إلى أنّ فصل (المسيح هل تنبّأ بالحسين؟) قد أثار اهتمام الكثيرين، واستأثر دون الفصول الاُخرى بجلّ النقد والاستحسان وكذلك الاستهجان، ودارت حوله
____________________
(1) سورة التوبة / 105.
المناقشات والتساؤلات، سيّما حول خطبة عيسى في تلاميذه قبل توجّهه للموت، وما عنته في كلماتها القليلة من معانٍ عمدت إلى تفسيرها بالشكل الذي ألهمته، وبالكيفيّة التي ترمي لها هذه المعاني في حقيقتها، مستنداً في ذلك إلى حجج دامغة أوردتها في متن الفصل المذكور إيّاه، وسأضيف لها بعض التفاسير والتحليلات الاُخرى ضمن هذه المقدّمة: قال عيسى في إنجيل يوحنا(1) : «إنّي ذاهب الآن إلى الذي أرسلني وما من أحد منكم يسألني: إلى أين تذهب؟ غير أنّي أقول لكم الحق: من الخير لكم أن أمضي، فإن لم أمض لا يأتكم المؤيّد؛ أمّا إذا مضيت فأرسله إليكم، ومتى جاء أخزى العالم على الخطيئة والبر والحكم».
وقد تركّزت المناقشات والتساؤلات حول ثلاث نقاط:
اُولاها: مَن المقصود بالمؤيّد. أليس الرسول محمّد (صلّى الله عليه وآله) هو الجدير بهذا القصد؟
وثانيها: الحسين شهيد وليس بنبي فكيف يتحدّث عيسى عنه، بينما لم يلمح إلى قدوم الرسول (صلّى الله عليه وآله) من بعده، مع أنّه نبي؟
وثالثها: لقد فسّرت كلمة المؤيّد في الإنجيل تحت معنى (الروح القدس) فكيف
____________________
(1) يوحنا 16 / 5 - 7 - 8.
احتملت اللفظة هذا التأويل المغاير الذي لم يقرأ إلاّ في هذا الكتاب؟
وهنا يجدر بنا الوقوف لتوضيح أمر لطالما تعامى عنه الغلاة المتطرّفون، ولازال يشكّل عقبة كأداء أمام منوّري القلب والفكر من العقلاء، أمام انطلاق أفكارهم وقناعاتهم المؤمنة، بأنّه ما من نبيّ غلا وتنبّأ مبشّراً بقدوم نبي بعده، وما من شهيد إلاّ وتنبّأ أيضاً بالشّهيد الذي سيليه، ولم يكن عيسى (عليه السّلام) ليشذّ عن هذه الحكمة الإلهيّة، لا تغافلاً عن تبشير الناس بقدوم النبي محمد (صلّى الله عليه وآله) ولا كرهاً لهذا التبشير أو هذا القدوم، (حاشا لله) وعيسى رسول المحبّة والسّلام، والمبشّر بالحبّ حتّى للأعداء والمبغضين، فكيف إذا كان الأمر يتعلّق بنبيّ بعده ختم الله به الأنبياء وبرسالته الديانات، وكان على هذا القدر العظيم من الشمائل النبويّة والخُلق الكريم؟
وللإجابة على مجمل التساؤلات يستحسن إعطاء نبذة عن نشأة الأناجيل الأربعة، والتي سار ويسير على تعاليمها العالم المسيحي، ولنحدّد أكثر (المسيحي الكاثوليكي) التابع لسلطة البابا في روما.
فالإنجيل المقدّس عرّبت لفظته إلى العربيّة من كلمة EUAYYEAIOV اليونانيّة، وهي تعني (البشرى الحسنة) ثمّ أطلقت على الكتاب الذي يحتوي هذه البشرى، وهو مجموع الأسفار الإلهيّة التي كتبت بإلهام الروح القدس خلال الحقبة الزمنيّة الممتدّة من القرن السادس عشر قبل المسيح حتّى آخر القرن الأوّل بعده، وإن كانت لفظه (إنجيل) هي كتاب القرن الأوّل قبل المسيح. فإنّ كتاب القرون التي سبقت
____________________
(1) تمهيداً وما بعدها العهد الجديد، المطبعة البولسية.
السنة الميلاديّة، دعي بـ (الكتاب المقدّس) وهو ينقسم إلى عهدين: (القديم. والجديد)(1) الأوّل يحتوي على الأسفار التي اُنزلت قبل السيّد المسيح وعددها 46 سفراً، وتنطوي على تاريخ وشعر وحكمة ونبوّة، والآخر يتضمّن الأسفار التي اُنزلت بعد ظهور المسيح، وفيها خلاصة حياته المقدّسة، وتعاليمه السّامية، وعددها 27 سفراً. فكان الكتاب القديم تمهيداً، والجديد تحقيقاً.
والإنجيل وضعه رسولان هما متّي ويوحنّا، وكلاهما عاينا وسمعا وعاشا ولمسا حياة المسيح عن قرب، وتلميذان هما مرقس ولوقا، وكلاهما رفيق حميم الأوّل لبطرس والآخر لبولس، وهما اللّذان تلقّيا الخبر عن رفيقيهما.
وعلّة الاختلاف الظاهر في أسلوب تدوين الروايات بين الأناجيل الأربعة، ترجع إلى ظروف المكان والزمان الذي كتبت فيه من قِبَل التلاميذ. فمتّي كتب إنجيله لليهود باللغة الآراميّة، وقد فقدت هذه النسخة بعد أن ترجمت إلى اليونانيّة، وقد غلب على رواية متّي اللغة الثقافية؛ لأنّه كتبها للمثقّفين، والبرهان على ذلك أنّه كتب الكلمة الوضعيّة على الصليب بثلاث لغات وهي: العبريّة واليونانيّة والرومانيّة. والتي تقول: (يسوع ملك اليهود). وقد أظهر الكاتب لليهود أنّ المعلّم الإلهي هو الماسيّا المنتظر، إذ به تمّت نبوءات العهد القديم وتحقّقت رموزه، فأكثر في إنجيله عبارة: (كما ورد في أشعيا وأرميا والأنبياء) أو (وهكذا تمّت الكلمة التي قيلت بيسوع)، كذلك لم يكن متّي ليحرص على تسلسل الحوادث التاريخيّة، فكان يجمعها
____________________
(1) العهد الجديد تمهيد، ط البولسية.
جميعاً بدون هذا التسلسل إذ كان المهم عنده إبراز الموقف بغضّ النظر عن توقيته الزمني، ويقال: أنّه ترجم إنجيله إلى اليونانيّة بنفسه.
أمّا مرقس تلميذ بطرس فقد وجّه إنجيله إلى الرومانيين باللغة اليونانيّة؛ ولأنّ هذا الشعب مغرم بالقدرة والعظمة، فقد أوقف وصفه على ما يظهر وجه المسيح من هذا القبيل، وهو ينقل عن بطرس وفي إنجيله تركيز على المعجزات التي اجترحها المسيح، مع أنّه لا يأتي على ذكر بطرس شخصيّاً.
أمّا لوقا تلميذ بولس فكان مثقّفاً وطبيباً ومصوّراً وخبيراً ضليعاً باللغة اليونانيّة، وقد وجّه إنجيله خصّيصاً لليونانيّين والرومانيّين المتنصّرين حديثاً، فأبان لهم أنّ رحمة المخلص - المسيح - لم تنحصر في فئة من الناس دون اُخرى، وكان لا يهتمّ بالتفاصيل التي أوردها غيره في أناجيله، وهو الذي ألّف أعمال الرسل، وكان يوجّه كلامه لـ (تيوفيلوس) بكلّ الاُمور التي جاء بها المسيح. مبتدئاً كلامه بعبارة: (سأحكي الحقيقة وليس كما زادوا عليها)، وقد انفرد إنجيله بإيراد أمثال الرحمة كالحروف الضال، والابن الشّاطر، حتّى دعي بـ (إنجيل الرحمة).
أمّا يوحنّا فقد كتب إنجيله بعد مئة سنة من المسيح؛ لذلك اختلف عن الأناجيل السابقة، وقد كتبه باليونانيّة ليحاجّ دعاة الضَلال المتنكّرين لناسوت المسيح أو لاهوته(1) ، وحرص على التسلسل التاريخي أكثر من غيره، وهدف به كلّ المسيحيين حيث حلّق بالفلسفة كثيراً، وهو المتأثّر بفلسفة اليونان وبالكلمة؛ لذا فقد بدأ إنجيله بعبارة (في البدء كان الكلمة)، وفي عهده انبثقت فئة أسمت نفسها (النقلاويّون) أنكرت اُلوهيّة المسيح، كما نشأت على عهده قصص شعبيّة
____________________
(1) الناسوت: طبيعة المسيح البشرية، واللاهوت طبيعته الإلهية.
وخيالية، وألّف إنجيل دعي (أبو كريف) وبدأت الأناجيل تكثر منذ عهده.
والإنجيل الذي نتلوه اليوم منقول عن المخطوطات الكبرى على الجلد التي تعود إلى القرن الرابع، منها المخطوطة الفاتيكانيّة، وقد نسخت حوالي سنة 348 م، والمخطوطة السّينائيّة وقد نسخت حوالى 331، والمخطوطة الإسكندريّة التي ترقى إلى القرن الخامس، وهناك مخطوطة رابعة معروفة بالأفراميّة؛ لأنّ نصّ الكتاب والإنجيل قد محي وكتب عليه مواعظ (مارأفرام) وقد تمكّن العلماء من إبراز النصّ الأصلي وقراءته، ويوجد أيضاً مخطوطات اُخرى نسخت ما بين القرنين الرابع والعاشر وهي نحو أربعين، وهناك أيضاً نحو ثمانية آلاف مخطوطة صغيرة.
ففي الفاتيكان والمتحف البريطاني وباريس يوجد ثلاثة مخطوطات أصليّة، وقد اكتشف (شتربيتي) مجموعة تشتمل على جزء كبير من الأناجيل، وهي ترجع إلى القرن الثالث. وفي سنة 1956 اكتشف مارتان بودمير أوراق بردي تتضمّن إنجيل يوحنّا كاملاً مع أجزاء من إنجيل لوقا، وهي تعود إلى أواخر القرن الثاني، كما اكتشف (جون رايلايد) أقدم مخطوطات البردي المحتوية على قسم من الفصل الثامن عشر من إنجيل يوحنّا، وجده في صعيد مصر، وهو يرقى إلى النصف الأوّل من القرن الثاني.
أمّا أقدم المخطوطات العربيّة لترجمة الكتاب المقدّس فموجودة الآن في (دير سيناء)، منها مخطوطة أعمال الرّسل والرسائل الجامعة، وهي من القرن الثامن ميلادي، ومنها مخطوطة المزامير بالخطّ الكوفي مع النصّ اليوناني، وهي من العام 800 م، وهناك عدد من مخطوطات الأناجيل الأربعة ترجع كلّها إلى القرن التاسع، ومخطوطةٌ للرسائل وسفر الأعمال وقد ذكر ناسخها تاريخ نسخها وهو عام 867 م، كما أنّ هناك بعض أسفار الأنبياء وأيّوب ترجع إلى القرن التاسع ميلادي،
وفي دير سيناء مخطوطة للتوراة من القرن العاشر، كما وجدت ترجمات قديمة إلى العربيّة يرجع عهدها إلى ما قبل الإسلام حيث كان المسيحيّون العرب في اليمن وبصرى إسكي شام يتعبّدون بها.
أمّا الأناجيل الأربعة فقد ترجمت للعربيّة منذ عهد (يوحنا الثالث) بطريرك السريان الأنطاكي (631 - 648 م)، وطبعت لأوّل مرّة في روميّة سنة 1951، وقد ظهرت ترجمات عربيّة عصريّة كاملة منذ عام 1865 في ثلاثة مجلّدات كبيرة حقّقها الآباء اليسوعيّون اللبنانيون.
وأخلص بعد هذا العرض إلى فكرة أنّ الأناجيل الأربعة التي وضعها الرسل المذكورون، كانت صريحة وصادقة وأمينة، ترجمت حياة المسيح بأكملها، لكن ما طرأ بعد وفاة يوحنّا، زاد من عدد الأناجيل كثيراً إذ شوّه البروتستانت بعض المرادفات، وألغوا بعضاً منها، وحوّروا البعض الآخر بما يتّفق مع عقيدتهم، وعلى سبيل المثال حذفهم كلّ ما يمسّ رئاسة بطرس للكنيسة الموحّدة.
وفي العالم المسيحي الآن ألف طائفة للبروتستانتيّة وحدها، ولكلّ منها إنجيل يختلف بشكل أو بآخر عن الآخر.
فقد جاءت وقت كان ثمّة فيه راهب يدعى (لوثيروس)، فتح عينَيه على رجال الدين الكاثوليك يتاجرون بـ (الغفرانيّة)، ويملّكون أماكن في الجنة بموجب شهادات رسميّة، سمّيت وقتذاك بـ (صكوك الغفران)، فأراد هذا الراهب أن يقوم بحركة إصلاح، فانشقّ عن السدّة البابويّة.
ولم يحاول البابا وقتذاك إصلاح الوضع الشاذ الذي أوجده رجال الدين من خلال بيعهم لصكوك الغفران، وقد قيل في عصرنا هذا: إنّه لو انشقّ لوثيروس في عهد البابا يوحنّا الثالث والعشرين الذي توفّي منذ عشر سنوات تقريباً، لكان أمر بإصلاح مثل هذا الخلل، ولم يسمح بالانشقاق، لكنّ المصالح الاقتصاديّة والأطماع المادّية، كانت تعصف برؤوس رجال الدين،
ممّا جعل الانشقاق أمراً حتميّاً.
وبعد لوثيروس جاء (كالفن) وجاء (المورمون) وجاء (الباتيست) و(السّبتيست) ومذاهب انشقاقيّة اُخرى، كلّ منها تحرّف في الإنجيل بما يتّفق ومعتقداتها الجديدة. فمنها ما ألغت الأسرار، ومنها ما نفت القدسيّة عن العذراء مريم (عليها السّلام) ومنها ما حرّفت الأحداث التاريخيّة كمسألة نوم العذراء في المغارة، وزيارة المجوس للمسيح في المزوّد... إلخ.
ولمّا استشرى الوضع وتفاقم الخلاف بين الكنائس المنشقّة، وكثرت الأناجيل حتّى غدت بعدد الطوائف المبعثرة، اجتمع المجمع المسكوني وقام بعمليّة غربلة كبيرة استبعد معها كلّ الأناجيل التي صدرت بعد عهود التلاميذ الأربعة، ومنها إنجيل (برنابا) الذي وصفه المجمع المذكور: بأنّه كُتِب بيد مرتدّ عن النصرانيّة، جدّ خبير بالتوراة اللاتينيّة، يصف فيه شتّى نواحي الحياة الدينيّة والمدنيّة والتاريخيّة والجغرافيّة والاجتماعيّة في عهد المسيح، على ما رأى بعينه في بيئته الإيطاليّة في القرن السادس عشر(1) .
إضافة لذلك كلّه أنّ يوحنّا ذكر في نهاية إنجيله عبارة تقول: وقال المسيح خلال حياته كلاماً كثيراً لو جُمع لَما احتوته أسفار.
إذاً فنحن هنا أمام تعدّد أناجيل كثيرة نقلت من لغة إلى اُخرى، وكُتبت في أزمان متفاوتة لتخدم غايات معيّنة، وحيال كلام كثير قاله المسيح ولم يدوّن. فإلى أين تقود هذه التشعّبات التي آلت إليها الأناجيل؟
المسيح تفوّه بكلام كثير، فماذا قال تُرى؟ ولِمَ لَم يدوّن قوله كلّه، وهو
____________________
(1) العهد الجديد ج تمهيد ط البولسية.
النبيّ العظيم المنزّه عن الخطأ والتكرار والتشابه في الأقوال والأفعال؟ وما كانت ستضمّ هذه الأسفار لو جُمعت كما ذكر يوحنّا في نهاية إنجيله؟ وما كانت ستضمّ أيضاً من صنائعه إضافة لأقواله كما جاء في يوحنّا؟(1) إذ ذكر: وضع يسوع أيضاً أشياء كثيرة اُخرى، لو أنّها كُتبت واحداً فواحداً لَما خلت أنّ العالم نفسه يسع الصحف المكتوبة.
هل كانت ستضمّ من الأقوال والصنائع المتشابه والمكرّر والمُعاد من الكلام والفعل النّبوي؟ هذه الأقوال التي فاقت فصاحتها كلّ فصاحة، وهذه الأفعال التي فاق إعجازها كلّ إعجاز.
وتلك الموجة العارمة من الأناجيل التي برزت والتي عني المجمع الكنيسيّ بغربلتها، ماذا أضافت للعقيدة المسيحيّة؟ وماذا ألغت من قوانينها وأسرارها؟ وما دورها في إغناء أو إفقار التعاليم المسيحيّة من خلال انتشارها؟
سؤال لطالما يرد إلى أذهان الكثيرين في غياب أيّ قبس مدوّن عن الكيفيّة التي تمّت فيها عمليّتا الغربلة والإقرار النهائي للأناجيل الحاليّة المتداولة من قِبَل المجمع المقدّس، والتي لا يرد في متنها أو مقدّماتها ما يفسّر ويوضّح الملابسات التي تعرّض لها الإنجيل حتّى وصل إلى الأيدي بشكله الحالي.
ولكنّنا كمسيحيّين مؤمنين لدينا غنى كامل في قناعاتنا بأنّ الأناجيل الأربعة المتداولة حالياً عن ألسنة التلامذة الأربعة هي الكتب الصّحيحة والكاملة للمسيحيّة، ولا ثقة البتّة بأيّة أناجيل غيرها، وما تساؤلنا إلاّ نوع من التعطّش إلى الحقيقة والظمأ إلى المعرفة.
فإذا لم يكن في هذه الأناجيل إشارة واضحة لتنبّؤ المسيح عن قدوم نبي من بعده
____________________
(1) يوحنا 20 / 25.
اسمه (محمّد)، فممّا لا شكّ فيه أنّ هذا المعنى متضمّناً إحدى آياته (عليه السّلام) حيث لم تسعف القوى التأمّليّة بجوهر ومعنى الدِّين الكلّي الواحد - عن عمدٍ أو عن غير عمد - بترجمة هذا المعنى ونحته من صلب الآيات؛ لأنّ رسول المحبّة بشّر وتكلّم لا بشكل مباشر، بل على سنّة الرموز والأمثال، وبغير مثل لم يكن يكلّمهم ليتمّ ما قيل بالنبي القائل: (أفتح فمي بالأمثال، وأذيع بالمكنونات منذ إنشاء العالم)(1) .
وهكذا على هذه السنّة شبّه المسيح ملكوت السموات بالحقل المزروع بالحنطة، وشبّه معتقدات الفريسيّين والهيروديسيّين بالخمير، حيث نهى تلاميذه عنه بقوله: (انظروا إيّاكم وخمير الفريسيّين وخمير هيرودس!) وهكذا.
فالرسل والأنبياء والأوصياء والمصطفون والشهداء، أعطاهم الله ملكة نورانيّة تساعدهم على استجلاء الغيب واستشفاف المستقبل، وفي الآية:( عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً * إِلاَّ مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ ) (2) ؛ دلالة على أنّ هذا العالم - عالم الغيب - تكشّف على أوسع نطاق للأنبياء والمرسلين، فاستشفّوا كلّ الأحداث التي ستليهم، ما يتعلّق منها بالأديان والمذاهب والمعتقدات، والتاريخ والجغرافيا والحركات السياسيّة.
ولا بدع في هذا القول، فمَن يقرأ الكتب السماويّة الثلاثة - خلا مزامير داود ونبوءات الرسل وأمثال سليمان - يجد أنّ أعظم الأحداث وأتفهها التي حدثت في الماضي، ولا تزال تحدث في قرننا هذا، والتي ستظل تحدث حتى انقضاء الدهور، قد ورد ذكرها في هذه الكتب: الوثنية، سدوم وعمورا، طوفان نوح، ظهور الأديان، عبور العبرانيين، دمار أورشليم وتشتّت اليهود، خراب بابل،
____________________
(1) متّي 13 / 35 مز 77 / 2.
(2) سورة الجن / 26- 27.
مذبحة كربلاء، فيضان النيل، اختفاء الأتلنتيك، ظهور إسرائيل، براكين تركيا، ظهور مادة النفط من باطن الأرض، ظهور الدجّالين باسم الأديان، سقوط عروش وممالك، قيام نظم، اختراع الطيران، اكتشاف الذرّة، الصعود إلى القمر، اكتشاف الكون، تقدّم الطب والعلوم، الإلحاد(1) ، وإضافة لما عايشته البشريّة حتّى الآن من الأحداث؛ فإنّ في طيّ هذه الكتب سجلاًّ كاملاً لأحداث ستلي خلال العقدين المتبقيين من القرن العشرين.
فإذا ما نظرنا إلى الإنجيل من هذه الزاوية، نجده زاخراً بكل المعاني والنبوءات، متضمّناً كل استكشافات المستقبل حتّى انقضاء الدهور. وعودة إلى الأناجيل بحثاً عن هذه النبوءات لتظهر منها الكثير في كلّ آية، فالمسيح (عليه السّلام) كانت له قدرة خصّه الله بها دون سائر الرسل، تكشف له الغيب حتّى انقضاء الدهور، فكيف بتلك الاستكشافات التي ستليه بعد خمسة قرون، حيث كان مقرّراً أن تنزل خلالها الرسالة السماويّة الثالثة التي أكملت الرسالة الثانية، والتي بشّر (عليه السّلام) بها، وشابهتها في جلّ تعاليمها وفي جوهرها السامي وبدعوتها إلى الحق الإلهي؟
هذه التعاليم التي سحرت النفوس فاستهوتها حتّى بلغ عددها منذ عهد النبي (صلّى الله عليه وآله) إلى وقتنا هذا معادلاً لعدد تلك الأنفس التي آمنت برسالة عيسى (عليه السّلام)؛ لأنّها وجدت في رسالة محمّد (صلّى الله عليه وآله) تتمّة وخاتمة لرسالته (عليه السّلام)، فبلغ بها الكمال الإلهي حدوده العليا، وارتقت وحدانية الله مداها من خلالها.
فكيف إذاً لا يجد المسيحي المتفهّم لروحيّة الإنجيل، أيّة إشارة متضمّنة أو منحوتة من إشارة متضمّنة إحدى الآيات لهذا الحدث العقائدي العميق الأثر
____________________
(1) الأسفار والمراثي والنبوءات.
لملايين النفوس، بينما نجد إشارات لأحداث بشريّة ماديّة عادية لا تبلغ مهما ارتقت معشار حدث نزول الرسالة المحمّديّة وانتشار عقيدة الإسلام فوق هذه الرقاع الواسعة من الأرض، وترسّخها في هذا العدد الهائل من النفوس البشريّة؟
وأنّا لواجدون في الإنجيل المقدّس تلميحاً لنزول آيات الرسالة الثالثة، إذ يقول السيّد المسيح لبعض الفريسيّين: «ما بال هذا الجيل يطلب آية! الحقّ أقول لكم: إنّه لن يُعطى هذا الجيل آية»(1) . فمثل هذا القول يشير إلى ترقّب نزول الآية على الأجيال التالية التي ستُعطى هذه الآية، وهذا الجيل لن يعايش المسيح بل نبيّاً غيره مع التضمين اللّفظي بأنّ الآية لا يلفظها إلاّ لسان نبي.
ويطالعنا أيضاً في إنجيل يوحنّا قولاً واضحاً لا مجرّد تلميح فحسب متضمّناً مجيء نبيّ بعد المسيح؛ إذ تقول شهادة يوحنّا المعمدان حينما أوفد اليهود إليه من أورشليم كهنة ولاويّين ليسألوه: مَن أنت؟ فاعترف وما أنكر، اعترف: إنّي لست المسيح. فسألوه: إذاً ماذا، أإيليا أنت؟ فقال: لست إيّاه. فسألوه: أالنبيّ أنت؟ أجاب: (لا). فسألوه وقالوا له: فلم إذاً تعمد إن كنت لست المسيح ولا إيليا ولا النبي؟(2) .
ففي هذا القول تسلسل سلّمي أثبت التاريخ صحّته من حيث ظهور الأنبياء، فقبل المسيح (عليه السّلام) جاء يوحنا يبشّر به، ثمّ جاء (عليه السّلام) وبعده جاء النبي محمّد (صلّى الله عليه وآله).
كذلك نجد في نفس الإنجيل إشارة اُخرى للنبي والمسيح، وذلك في وصف خطبة عيسى في اليوم الأخير العظيم؛ إذ قال: «إن عطش أحد فليأت إليّ ويشرب،
____________________
(1) مرقس 8 / 12 - 13.
(2) يوحنا 177 / 20 - 21.
مَن آمن بي فستجري من جوفه كما قال الكتاب، أنهار ماء حي»(1) .
وإذ سمع بعض الجمع هذا الكلام، وقالوا: لا جرم إنّ هذا هو النبي. وقال آخرون: بل هو المسيح. وقال غيرهم: أمن الجليل يأتي المسيح؟(2) .
ولنلاحظ صيغة الأسئلة التي وجّهت إلى يوحنا، وصيغة أجوبته عليها، فقد أجاب بعد أن سُئل مَن أنت، بقوله: (إنّي لست المسيح). وأجاب بعد أن سُئل عمّا إذا كان هو إيليّا، بقوله: (لست إيّاه). وأجاب بعد أن سُئل عمّا إذا كان هو النبي، قوله: (لا).
وكلمة (النبي) كما وردت في شهادة يوحنّا كان بصيغة معرفة (النبي) لا نكرة (نبي) كي تفسّر على أنّها صفة قد تطلق هكذا لمجرّد التساؤل حول هويّة يوحنّا، وهل هو نبي ما اُوتي مقدرة ما؟ أو بشر عادي؟ بل سبقت بـ(أل التعريف)، فانتقلت كلفظة نكرة تدلّ على مجهول غير منتظر، إلى معرفة تدلّ على معلوم منتظر، بما يشير إلى أنّ النبي المقصود قد أجمعت النبوءات على تحديد أوصافه واسمه، وعلى تسلسل ظهوره في سلّم ظهور الأنبياء، وعلى مكانته النبويّة بينهم، وعلى انتظار البشر لمجيئه بعد المسيح مباشرة.
وفي منظور التسلسل اللّفظي الذي جاء في شهادة يوحنّا (المسيح، إيليا، النبي) نلاحظ أنّ لفظة (النبي) كانت مسبوقة وليست متبوعة بأيّ اسم آخر، وبأنّها ختمت هذا التسلسل بتواجدها في نهايته. وفي هذا الاختتام انسجام تام مع ما ورد
____________________
(1) يوحنّا 193 / 37 - 38.
(2) يوحنّا 193 / 40 - 41.
في الكتب السماويّة والتواريخ الوضعيّة المدوّنة والتي لم تسجّل ظهور نبيّ بعد عيسى مباشرة أطلقت عليه صفة (النبي)؛ حيث لم يظهر بعده نبي، إلاّ النبي محمّد (صلّى الله عليه وآله) خاتم الأنبياء والمرسلين.
وحتّى الإنجيل المقدّس لم يفسّر المعنى المقصود بـ(النبي) كما ورد في شهادة يوحنّا، والذي ينتظر مجيئه بعد المسيح، كي يقال: بأنّ أي تفسير مغاير له يجافي الحقيقة والتاريخ.
فإذا قلت ذلك من قناعتي كمسيحي مؤمن فَهم تعاليم عيسى وما هدفت إليه وتعمّق في جوهر مبادئه السّامية، فلا يحمّل قولي بأكثر من حدود ما رمى إليه، ولا يؤخذ على أنّه تحميل لآيات الكتاب المقدّس تآويلاً لا تحتملها، حاشا لله، بل كما سبق وأسلفت من أنّ قناعتي كاملة بوجود ما يشير إلى مثل هذا الحدث - حدث نزول رسالة محمد (صلّى الله عليه وآله) - في صلب آيات الإنجيل، ولكن استخلاصها من مضانّها يحتاج إلى عقل ملهم، وضمير متبصّر نيّر، وشجاعة أدبيّة مؤمنة لا تخاف الجهر بقناعاتها وتحليلاتها الموضوعيّة العقلانيّة، فلم تك أبداً رسالة المسيح، رسالة تقوقع أو بغض، ولا حتّى رسالة نرجسيّة وعشق ذات، فالمسيح (عليه السّلام) قال: «لا تظنّوا أنّي جئت لأنقص الناموس أو الأنبياء، إنّي ما جئت لأنقص بل لأكمل»(1) .
ففي هذه القولة مغزىً مؤدّياً إلى ما يلي معنى الإكمال المتبوع بـ(الاستمراريّة) المؤدّية بدورها إلى الخاتمة.
فإذا اعترفنا بأنّ الأديان إنّما جاءت لجميع البشر على السواء، فنكون قد كرّسنا حقيقة أزلية تتجلّى في حكمة نزول الرسالات الثلاث واختتامها برسالة الإسلام.
____________________
(1) العهد الجديد 9 / 17.
فعيسى (عليه السّلام) قال لمجموع البشريّة: (ما جئت لأنقض بل لأكمل). وكان يريد إفهام النّاس بأنّه يكمل ما كان قد بدئ من دين الله الواحد برسالة اليهوديّة التي تشكّل اُولى مراحله، حيث أعقب هذا القول تضميناً لفظياً باستمراريّة مسيرة الرسالات لتصل نحو نقطة النهاية - الخاتمة - والقرآن الكريم خاطب مجموع البشريّة بالقول:( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلاَمَ دِيناً ) (1) . والمقصود في هذه الآية الكريمة: بأنّ ما كان في مسالك دين الله الواحد من رسالات جاء الإسلام ليكملها ويضع لها الخاتمة، فتمّت نعمة الله على البشريّة بتمام هذه الرسالات.
فمعنى عبارة( أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) يجيء مشيراً بشكل ضمني وواضح إلى وجود هذا الدين فيما سبق، ومسلّماً ببداهة هذه الكينونة السابقة بشكل منقوص، حيث أكملت اليوم بالشكل المرسوم الذي أرادته العناية الإلهية. أمّا عبارة( وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلاَمَ دِيناً ) فإنها جاءت بعد عبارة( وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ) الواقعة بدورها بعد عبارة( أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) ؛ فبذا يكون الإسلام هو الدين البشري الذي رضيه الله لعباده سواء أكانوا يهوداً، أم نصارى، أم مسلمين. وتكون اليهوديّة والمسيحيّة هما الأدواء الروحيّة التي عالجت الأنفس في أزمان نزولها، فبرّأتها إلى حين نزول الإسلام حيث أكملها وحصّن الأنفس بطعم روحي سرمدي، درأ عنها كل العلل والأسقام التي قد تطرأ عليها فتفنيها.
فالدين الواحد برسالاته الثلاث كان رحمةً للبشر، وأمراً لهم بعبادة الله
____________________
(1) سورة المائدة / 3.
الأحد. ولم يختصّ منهم أحداً دون الآخر بل قالت عزّته:( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) (1) .
وقد عرّفت الرسالات السماويّة الثلاث البشر بالله الأحد، وأوصلت لهم دينه الإلهي الواحد، مصداقاً لقوله تعالى:( شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ) (2) .
كما ورد ذكر الإله الواحد والدين الكلّيّ الشمول في الآية الكريمة:( وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ) (3) .
فعبارة( آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ ) فيها أبين دلالة على وحدانيّة الله، ووحدانيّة الأديان، ووحدانيّة التّنزيل، ووحدانيّة الإسلام بين الإسلام والمسيحيّة.
وقد جاء في القرآن الكريم:( وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ * وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنْ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنْ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ) (4) .
ففي كلّ هذا مصداق للقول: بأنّه لا يصحّ إسلام المسلم حتّى يؤمن بنبوّة عيسى (عليه السّلام)
____________________
(1) سورة البقرة / 21.
(2) سورة الشورى / 13.
(3) سورة العنكبوت / 46.
(4) سورة المائدة / 83 - 84.
ولا تصحّ نصرانيّة المسيحي حتّى يؤمن بنبوّة محمّد،( وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ) (1) .
هذا التعدّد في الخلق وفي الرسالات، هو في جوهره كتعدّد روافد نهر واحد يصبّ آخره في خضمّ محيط واسع. وهذا التعدّد لا يعني التفرّد أو الخصوصيّة، بل يشبه دور عدّة أعمدة تحمل مبنىً واحداً، يتوزّع ثقله بالقسطاس على كلّ واحد منها. فرسالة الرسالات تشابهت، ٍكذلك تعاليمها ومبادئها. وقد ناقش المجمع المسكوني علاقة الكنيسة المسيحية مع بقيّة الأديان(2) ، كما قارن بين الأديان التوحيديّة الثلاث: اليهوديّة، والمسيحيّة، والإسلام، وأبرز قواسمها المشتركة، وحدّد سماتها المتشابهة.
أهم هذه القواسم كما تحدّدت؛ الدعوة إلى عبادة الله الأحد، خلود النفس، الآخرة، الله خالق، الثواب والعقاب، الفضائل والأخلاق الحسنة، الزكاة والصدقة والبرّ والإحسان، الملائكة والشياطين،
____________________
(1) سورة المائدة / 48
(2) كان ذلك على عهد يوحنا الثالث والعشرين، وأكمله بيوس السادس، وقد دعي ممثّلوا الديانات الأخرى غير التوحيديّة لحضور الجلسات كمراقبين.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التعامل بالحسنى، تحريم القتل والزّنا وشهادة الزّور والسرقة، تكريم الوالدين.
وقد تبيّن للمجمع المسكوني أنّ الوصايا العشر في المسيحيّة يقابلها وصايا شبيهة في الإسلام، ففي الإنجيل ثمّة وصيّة تقول: «أحبب عدوك وقريبك كنفسك». وفي القرآن ثمة اُخرى تقول:( وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ.. ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ) (1) . والاثنتان تدعواننا للتأمّل في مغزاهما ومراميهما ومعاني ألفاظهما.
كذلك فإنّ قصّة خلق الإنسان على صورة الله ومثاله، ومدّة الخلق التي هي ستّة أيّام، واستراحة الخالق في اليوم السابع كلّها متشابهة شبهاً كبيراً ما بين الإنجيل والقرآن.
والمطّلع على الكتابَين المقدّسين، سيجد تطابقاً غريباً في معظم القصص والأحداث، وتشابهاً بيّناً بين المبادئ والأهداف، وما قصّة استخلاف الله لآدم في الأرض إلاّ إحدى هذه التطابقات المتجانسة.
وهكذا شاءت حكمته تعالى أن يسلّم من الناس أمره لعزّته عن طريق الإنجيل، ومنهم الآخر عن طريق القرآن، ومنهم عن طريق الحكمة؛ لأنّ الإسلام هو التسليم بالأمر لله تعالى، توزّعت نعمه على الخلق بسواسية عادلة، فكان دين البشريّة على اختلاف أديانهم ونحلهم.
____________________
(1) سورة فصّلت / 34.
وبدين الإسلام هذا وصّى إبراهيم (عليه السّلام) بنيه، وبه وصّى حفيده يعقوب أي إسرائيل بنيه،( إذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ) (1) .
وطريق الهدى واحدة ملّة إبراهيم، الإسلام، وعليها كان إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى. والمؤمنون يؤمنون بما اُوتي النبيّون، لا يفرّقون بين أحد منهم، ويسلّمون لله، وبلَون الإسلام يصطبغون. الذين يؤمنون هذا الإيمان هم المهتدون، اُولئك لا يجادلون في الله تعصّباً لأهوائهم، بل يخلصون لفطرة الله ولا يتفرّقون(2) .
فطرة الله هي اختياره تعالى لقافلة أنبيائه من ذريّة واحدة، بعضها من بعض، لتكمل دعواتهم بعضها بعضاً أيضاً؛ لأنّها في تمامها دعوة إلهيّة واحدة، إذ قال تعالى:( إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ * ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (3) .
فإذا كان الخط البياني للتوحيد بلغ في الرسالة المحمديّة إلى الذروة (قل هو الله أحد) فإنّ التوحيد في المسيحيّة يبرز في مطلع فعل الإيمان، إذ جاء فيه: (نؤمن بإله واحد ضابط الكلّ خالق السماء والأرض وكلّ ما يُرى وما لا يُرى).
أمّا التثليث (الأب والابن والروح القدس) فإنّه تعبير مجازي أدبي، لا حقيقي مادّي، أو كما يفسّره البعض من أنّ لله ثلاثة أقانيم منفصلة، إذ الأصحّ أنّها أقانيم
____________________
(1) سورة البقرة / 133.
(2) تفسير القرآن المرتّب للدكتور أسعد علي / 364.
(3) سورة آل عمران / 33 - 34.
متّصلة متداخلة تعبّر المجاز في ثلاث نقاط نحو الحقيقة، ويصحّ تشبيه هذا المجاز اللفظي، بقولنا عن الشمس: بأنّها مكوّنة من نار وضوء وحرارة، تشكّل مجتمعة قرصاً واحداً يدعى الشمس. يُعرف بها ولا تُعرف به، ولا تشكّل مفردة عالماً أو كوناً قائماً، تُعرّف من قريب أو بعيد على ذات ما عُرّفت به مجتمعة.
وتعدّ وحدانيّة الله الحقيقة الأساسيّة التي يعلّمها الكتاب المقدّس، فقد جاء على لسان أشعيا النبي: (أنا الأوّل وأنا الآخر ولا إله غيري). ثمّ جاء المسيح وثبّت هذه الحقيقة بقوله «إنّ الربّ إلهنا ربّ واحد»(1) . ثمّ انطلق الرسل بعده يعلّمون هذه الحقيقة، فقد كتب بولس الرسول إلى أهل أفسس: (للجميع ربّ واحد وإيمان واحد وإله واحد هو فوق الجميع ومع الجميع وفي الجميع)، وصرّح لأهل كورنتس: (نحن نعلم أنّ الوثن ليس بشيء في العالم، وأنّه لا إله غير واحد)(2) . وتقول أولى الوصايا العشر: (أنا الربّ إلهك لا يكن لك آلهة أخرى تجاهي). وكتب لوقا: (للربّ إلهك تسجد، وإيّاه وحده تعبد)(3) .
ولمّا كان عقل الإنسان محدوداً غير قادر على سبر جوهر الله والوقوف على سرّ طبيعته،
____________________
(1) مرقس 12 / 29.
(2) رسالة بولس إلى الكورنثيين 329 / 4 - 5.
(3) لوقا 4 / 8.
فقد شاءت عزّته أن يعلن عن سرّ ماهيّته العميق، فكلّم البشر بواسطة أنبيائه. ولمّا قام البعض بنفي الاُلوهيّة عن الثالوث السرّي التام أقطاب الكنيسة، وحدّدوا عقيدة الثالوث، فاستعانوا بكلمتي (أقنوم) و (طبيعة) ليعبّروا بها عن الله الواحد، وجعلوا عبارة: (بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد) بداية الصلاة.
وإنّا لواجدون في سفر التكوين تلميحات إلى الأقانيم الثلاثة، قال الله بصيغة الجمع: (لنصنع الإنسان على صورتنا كمثالنا)(1) . وجاء فيه أيضاً: (هلمّ نهبط ونبلبل لغتهم)(2) .
كما يروي لنا أشعيا النبي أنّه رأى في السماء مجد الله وسمع السرافين - إحدى طغمات الملائكة - يقولون: (قدّوس قدّوس قدّوس، ربّ الجنود، الأرض كلّها مملوءة من مجدّه)(3) . فتكرار كلمة قدّوس ثلاث مرات موجّه إلى طبيعة الأقانيم الثلاثة.
أمّا الاُقنوم الثاني الذي هو الابن، أي المسيح فقد لمح إليه داود النبي في قوله: (الربّ قال لي أنت ابني، أنا اليوم ولدتك)(4) .
وقال أيضاً: (قال الرب لربّي: اجلس عن يميني، في بهاء من الجوف قبل الفجر ولدتك)(5) .
____________________
(1) سفر التكوين 1 / 26.
(2) المصدر نفسه 11 / 7.
(3) أشعيا 36.
(4) المزامير 2 / 7.
(5) المصدر نفسه 109 / 1 - 3.
وفي العهد الجديد كشف عن سرّ الثالوث، إذ قال جبرائيل الملاك وهو يبشّر العذراء مريم (عليها السّلام): (إنّ روح القدس يحلّ عليك، وقوّة العلي تظلّلك؛ ولذلك فالقدّوس المولود منك يدعى ابن الله)(1) .
وعندما عمد يوحنا المسيح في نهر الأردن انفتحت السماوات ونزل الروح مثل حمامة فوق رأسه وصاح صوت: (أنت ابني الحبيب بك سررت)(2) . هذا ويدعو القدّيس يوحنا الأقنوم الثاني بـ(الكلمة) المتميّز عن الاُقنوم الأوّل فيقول: (في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وجاء إلى خاصّته، والكلمة صار جسداً)(3) .
والروح القدس هو اُقنوم ثالث؛ لأنّ كلمتَي (الروح القدس) و (الله) تأتيان متناوبتين مترادفتين، جاء في أعمال الرسل: (يا حنانيا، لماذا ملأ الشيطان قلبك حتى تكذّب على الروح القدس؟ إنك لم تكذّب على الناس بل على الله)(4) .
وهكذا نرى أنّ تعليم الكتاب عن تثليث الأقانيم في الله لا يمكن أن يتّفق مع التعليم عن الوحدانيّة ما لم تكن للأقانيم الثلاثة طبيعة واحدة غير منفصلة، لا تشكّل إحداها منفردة، أي طبيعة أو خاصيّة مميّزة، فلو أمكن الفصل بين الأقانيم لكان في الطبيعة الإلهيّة تعدّد وكثرة، إذ إنّ الله تعالى روح محض في منتهى البساطة، ولا يوجد فيه تأليف أو تركيب، وفي التطرّق إلى أبوّة الله، ليس المقصود فيها أنّ لله ولداً على طريقة البشر، أو بحسب المفهوم البشري، بل إنّ هذه الأبوّة تحمل معنى الصدور، كما يصدر النور من الشمس.
____________________
(1) لوقا 1 / 35.
(2) مرقس 1 / 11.
(3) يوحنا 1 / 1 - 2 - 3.
(4) أعمال الرسل 5 / 3 - 5.
ولكن كيف ستوفّق عقول العامّة بين صدور النور من أحد المصادر ثمّ بقائه في هذا المصدر؟ إذ قيل لهم: إنّ صدور الابن في هذا المقام يشبه إلى حدّ ما صدور القصيدة من قريحة الشاعر؛ فهي وليدة فكره وإنتاج مخيّلته، فيخطّها على القرطاس وتتناولها الأيدي، ولكنها تبقى في الوقت نفسه راسخة أبداً في مخيّلته.
وقد شبّه بعض اللاهوتيين - تقريباً للأذهان - علاقة الأقانيم الثلاثة في الطبيعة الإلهيّة الواحدة بمثلّث متساوي الأضلاع والزوايا، تضمّ كلّ زاوية بين ضلعيها مساحة المثلّث بكامله وبالتساوي، وتتميّز فيه كلّ زاوية عن الأخرى، فكما أنّ للزّوايا الثلاث مساحة واحدة متساوية كليّاً، وأنّه لا يمكن الفصل بينها ما دام هناك مثلّث. فكذلك لكلّ من الأقانيم الثلاثة، الطبيعة الإلهيّة الواحدة، وأنّه لا يمكن الفصل بينهم.
وهكذا فإنّ المسيحيّة لا تؤمن إلاّ بإلهٍ واحد؛ لأنّها توحيديّة؛ ولأنّها بالتالي واحدة من مراحل التنزيل، وواحدة من مراحل الرسالات السماويّة:( وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ) (1) .
أمّا المؤيّد الذي عناه المسيح فلا يمكن أن يكون النبي محمّد (صلّى الله عليه وآله)؛ لسبب جوهري وهو أنّ الرسول ليس لديه السلطة العلويّة على إرسال رسول مثله، بل اختصّت هذه السلطة بيدَي الله جلّ جلاله، باعث الرسالات من لدنه، وفي كلمة عيسى (عليه السّلام) لتلاميذه مصداق لذلك، إذ قال: «الحقّ والحقّ أقول لكم، ما كان عبدٌ أعظم من سيّده
____________________
(1) سورة العنكبوت / 46.
ولا كان رسولٌ أعظم من مرسِله»(1) . وقال أيضاً (عليه السّلام): «مَن قَبِل الذي أرسله قَبِلَني، ومَن قَبِلَني قَبِل الذي أرسلني»(2) .
فهنا ثمّة تعبيران واضحان لا لبس فيهما يؤكّدان على أنّ ثمّة قوّة عُليا لا سيطرة للمسيح عليها هي التي أرسلته، وهي قوّة أعظم منه، وهو كرسول يمثّل الطاعة لهذه القوّة والامتثال لمشيئتها، فكيف ستكون له سلطة إرسال نبي مثله وهو المرسل من لدن الله؟
وللجواب على ثاني التساؤلات حول المؤيّد، يمكن القول: بأنّ المسيح حينما تكلّم عنه فإنّما كان يتكلّم بصفته شهيداً لا نبيّاً، وقد تكلّم عن شهيد يكمل شهادته ويؤيّدها بين الناس، ولم يكن يتضمّن معنى عبارته (أرسل لكم المؤيّد) التأييد لنبوّته، بل لشهادته التي أكملت بتمامها شهادات مَن سبقه (عليهم السّلام)، إبراهيم وإسحاق وزكريا وموسى ويحيى وغيرهم، والتي ستكملها بدورها شهادات مماثلة على زمن الرسالة الثالثة التي سيتمّ تعالى بها عهد الرسالات.
ولتوضيح التساؤل حول كلمة المؤيّد، ولِمَ أوّلت في هذا المؤلّف بالشكل الذي بدت به؟ بينما فسّرت في الإنجيل المقدّس بأنّها الروح القدس. فإنّ في العَودة إلى فصل (المسيح هل تنبّأ بالحسين؟)(3) إجابة وافية على ذلك، توضّح في الوقت ذاته أسباب تفوّه المسيح بهذه العبارة، مع تحليل موسّع يجيب على مختلف
____________________
(1) يوحنا 13 / 16 - 17.
(2) المصدر نفسه 13 / 20.
(3) الحسين / 295.
الاستفسارات التي قد تجول في ذهن القارئ المتعطّش لتحليلٍ وافٍ مقنعٍ.
وتوخّياً لإعمال فكر القارئ، ورغبةً في جعل تأمّلاته مَعبراً إلى الحقيقة الحرّة، يتوصّل إليها بقدراته الفكريّة الذاتيّة، فقد عمدنا في هذا الفصل إلى تغيير عنوانه السابق من (المسيح يتنبّأ بالحسين) إلى (المسيح هل تنبّأ بالحسين؟). فنقلناه بهذه الصّيغة من صفة الجزم المطلق إلى صفة التساؤل المحرّك لرغبة البحث والتفكير، مع الإبقاء على مقصد التضمين الجازم بصدد النبوءة، حتّى في باب التساؤل الذي تركناه مفتوحاً ليلج منه فكر القارئ إلى محراب التأمّل، فالمعرفة، فالحقيقة، دونما توجيه أو إيحاء من جهتنا.
وجعلنا متن الفصل متلائماً مع عنوانه الجديد بما يحقّق الهدف الآنف الذكر، فالحقائق السماويّة لا تطال أعتابها إلاّ بالتأمّل والتحليل، والتحليق نحوها بجناحي البصيرة الملهمة، إلى حيث مصدر ذبذباتها، ومبعث إيحاءاتها العلويّة.
وأخيراً فإنّ سؤالاً: لِمَ الحسين بالذات دون سائر أعلام الإسلام موضوعاً للكتاب؟ لطالما رُفع في معظم ما قيل وكتب حول الكتاب، ويأتي الجواب بتساؤل مردود: (ولِمَ لا يكون الحسين بالذات؟ أيكره أحدنا الحقّ ورافعي لواءه؟! ولِمَ لا يحبّ المؤمن أيّاً كان دينه، مَن أحبّه النبي (صلّى الله عليه وآله) واعتبره بضعة منه: «حسين منّي»، واعتبر نفسه جزءاً منه: «وأنا من حسين».
أيرفض مطلق إنسان - سيّما إذا كان مسيحياً - أن يكون ذلك المؤمن الذي ترقد في قلبه حرارة قتل الحسين التي لا تبرد أبداً، تيمّناً بقول الرسول الكريم: «إنّ لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبداً»(1) ؟ ومَن ذا الذي لا يحبّ
____________________
(1) مستدرك الوسائل 2 / 217.
مظلوماً كالحسين المظلوم، ولا يجد في حبّه راحةً لضمير حي، وسعادةً لفكر أصيل، ورضىً لقلب يترع بالإيمان؟
فشخصيّة كالحسين اختصّت بشمائل النبوّة، لا يعثر المطّلع في سِفر حياته على موقف رخو أو متخاذل، فلا يملك إلاّ أن يعجب به ويحبّه، ويجد في الاستجابة لهذا الإعجاب وهذا الحبّ مودّة قلب، ومودّة قربى: ( قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ) (1) .
كيف تولّدت فكرة الكتاب؟ وما لغته؟ سُئِلت عن هذا.
لقد اعتدت أن أعايش شخصيّة الحسين (عليه السّلام) ساعتين يوميّاً؛ بقصد الاطّلاع على مجريات أحداث كربلاء، وفي الوقت ذاته الإلمام بالأبعاد القدسيّة والبشريّة لشخصيّة مفجّرها، فتوفّر لي بعد فترة من القراءة والاطّلاع على جوانبها ومعطياتها، رؤية معيّنة لا تمتّ إلى الرؤى التي تكوّنت عنها بصلة. وكما أسلفت فإنّي كثيراً ما تحسّست خلال قراءتي أو كتابتي لسيرة الحسين (عليه السّلام) غفلة الكتّاب والمؤرّخين المسلمين عن الجوانب المميّزة لشخصيّة سبط النبي، ورددت ذلك إلى كون هؤلاء الكتّاب والمؤرّخون يعيشون وسط الصورة، لا خارجها، فرأيت أنّ ما توفّر لديّ من رؤى وآراء كان من خارج الصورة، حيث وضحت زوايا عديدة خافية.
ورأيتني بعد سنتين من القراءة في سيرة أبي الشهداء أبدأ بترتيب أفكاري ورؤاي وآرائي لأمضي بعدها سنة اُخرى في وضع الكتاب على ضوء ما توفّر لي وعلى هدي ما استلهمته بعَون الله من أفكار وإلهامات.
والآن حينما اُعيد قراءته يتأكّد لي بأنّني كنت خلال كتابته واقفاً تحت تأثير وإلهام، ما كنت قادراً على إنجازه بدون عونهما، فأشكر الله وأتيقّن من شمولي
____________________
(1) سورة الشورى / 23.
ببركة ريحانة الرسول المذبوح ظلماً والمستشهد دون حقّ الله فوق ثرى كربلاء المقدّسة.
إلهام يلازم الفكر في الصّحو والمنام، ويلبّي هتاف وحي رجّاف انبثق له من أعماق الدهور، يستحث من أعماق السريرة للإفصاح والتدوين، وإضافة جديد على سيرة الحسين العطرة وثورته الخالدة، فكان إيحاء يهدف لإتمام واجب، وإلهاماً يعين على إتمامه بقدر ما يتنادى له الفكر الحي، والضمير المنوّر.
وهكذا فإنّنا كثيراً ما نقف نحن البشر الضعفاء لنتساءل: لِمَ فعلنا هذا؟ ولِمَ أقدمنا على فعل ذاك الأمر؟ ناسين أنّ ثمّة قوّة علويّة هي التي تُنفذنا إلى إتمام هذا الأمر أو ذاك، وتسدّد خطانا جزاء طاعتنا، أو تعثر بنا هذه الخطى جزاء عقوقنا واستهتارنا بكلّ ما هو قدسي. هكذا انبثقت فكرة الكتاب.
أمّا عن لغته واُسلوبه، فقد وضعت في اعتباري منذ البداية أن تكون اللغة سهلة، واُسلوب العرض والتحليل موضوعيّاً. ففي البداية تساءلت: بأيّة لغة أكتب؟ هل استخدم لغة تاريخيّة تنسجم مع التاريخ الذي تغرف منه؟ أم أكتب بلغة أدبيّة عقيمة؟ أم بلغة فلسفيّة عسرة؟ وأخيراً رأيت أن تكون اللغة بسيطة بساطة الموضوع الذي تطرقه، وعميقة عمق هذه البساطة، فما دامت شخصيّة الحسين (عليه السّلام) هي محور البحث، وهي في ميزان البساطة والتعقيد، بسيطة كالحقّ، واضحة كنور الشمس، فلتكن اللغة المبرّزة لصفاتها هذه في مستوى بساطتها وعمقها ووضوحها.
وهكذا كانت لغة الكتاب وسطاً بين الأدب والصحافة المثقّفة، تأخذ من الأدب جماله، ومن الصحافة إيقاعها السهل الممتنع.
لكن ذلك لم يمنعنِ من إعطاء كلّ حدث ما يوافقه من لغة وأسلوب، بغضّ النظر عن الهيكل العام للكتاب؛ وذلك بهدف إعطاء العمل جديّة البحث، وسلاسة التحقيق، ورشاقة العرض البعيد عن الإنشائيّة والتقريريّة، وتكرار ما سبق تكراره، بحيث ينسجم هذا كلّه مع الهدف الذي رميت إليه، ألا وهو إخراج بحث تحليلي صرف، لا يقرب من السرد التاريخي إلاّ فيما يخدم الفكرة فحسب؛ لأنّي لست مؤرّخاً، بل كاتباً يبحث في التاريخ عن الإنسانيّة، ومواقف الإنسان. وهكذا كانت الفكرة وأيضاً اللغة.
ويظلّ الحبّ ومن رحابه تطلّ المحبّة، ناشرة ضياءها ما بين السطور والكلمات، ويفرز قلم المؤمن مداد قلبه، كلّما تحسّ روعة الاستشهاد، وتبرز عظمة المضاء، وتصوّر هلع السرائر والحنايا من هَول الفاجعة.
فإذا الله (جلّ شأنه) فدى إسماعيل من الذبح بعد أن صدّق أبوه الرؤيا وتلّه للجبين. فهل يرضى سبحانه بذبح الحسين ابن بنت رسوله؟! وكم كان غضبه عظيماً حين ذبح فداءً للحقّ الإلهي، وهو الصادق الأمين على هذا الحق، وعلى سنّة الله في خلقه! وكم هو حريّ بنا نحن البشر الضعفاء لأن نقف بقلوب حزينة، وعيون دامعة أمام أحداث هذا الذبح الذي لم تسجّل الأديان والتواريخ ما يعدله سموّ معنى، وسموّ ذات، وعلوّ شأن.
فهو ذبحٌ فدى البشريّة جمعاء، وصان دين الله الواحد من الانتهاك.
وهو ذبيح أرسى للبشريّة مجدها الذي ترتع في نعمته الآن وإلى أبد الدهور. ويأبى الله إلاّ أن يتمّ نوره.
فسلام عليه سيّداً للشهداء، سلامٌ عليه يوم ولد، ويوم مات، ويوم يبعث حيّاً
أنطون بارا
دمشق في 7 / 7 / 1979
ثورة الحسين لمَن؟
لم تحظَ ملحمة إنسانيّة في التاريخَين القديم والحديث، بمثل ما حظيت به ملحمة الاستشهاد في كربلاء من إعجاب ودرس وتعاطف، فقد كانت حركة على مستوى الحدث الوجداني الأكبر لاُمّة الإسلام، بتشكيلها المنعطف الروحي الخطير الأثر في مسيرة العقيدة الإسلاميّة، والتي لولاها لكان الإسلام مذهباً باهتاً يركن في ظاهر الرؤوس، لا عقيدةً راسخة في أعماق الصدور، وإيماناً يترع في وجدان كلّ مُسلم.
لقد كانت هزّة وأيّة هزّة. زلزلت أركان الاُمّة من أقصاها إلى أدناها، ففتحت العيون، وأيقظت الضمائر على ما لسطوة الإفك والشرّ من اقتدار، وما للظلم من تلاميذ على استعداد لزرعه في تلافيف الضمائر؛ ليغتالوا تحت سترٍ مزيّفة قِيَم الدِّين، وينتهكوا حقوق أهله، ويخمدوا ومضات سحره الهيوليّة.
كانت ثورة بمعناها اللفظي، ولم تكن كذلك بمبناها القياسي؛ إذ كانت أكبر من أن تستوعب في معنى لفظي ذي أبعاد محدودة، وأعظم من أن تقاس بمقياس بشري.
كانت ثورة رَقَت درجات فوق مستوى الملحمة، كما عهدنا الملاحم التي يجاد
بها بالأنفس. فأيّة ملحمة هي استمدّت وقود أحداثها من عترة النّبي وآل بيته الأخيار (عليهم السّلام)؟ وأيّة انتفاضة رمت إلى حفظ كيان اُمّة محمّد وصون عقيدة المسلم، وحماية السنّة المقدّسة، وذبّ أذى المنتهكين عنها؟
فإذا نظرنا إليها بمنظار الملاحم، لم يفتنا ما فيها من كبر فوقها. فالملاحم والثورات التي غيّرت مجرى التاريخ والاُمم، تقاس عادةً بمدى إيجابيّة وعظم أهدافها، وإمكانيّة تساميها إلى مستوى العقيدة أو المبدأ لمجموع فئة ما أو فئات؛ وعلى هذا المقياس تكون ثورة الحسين (عليه السّلام) الاُولى والرائدة والوحيدة في تاريخ الإنسانيّة مذ وجدت وحتّى تنقضي الدهور؛ إذ هي خالدة خلود الإنسان الذي قامت من أجله.
(اُولى) ؛ لأنّها في إطارها الديني هي أوّل ثورة سجّلت في تاريخ الإسلام، وفي تاريخ الأديان السماويّة الاُخرى، على مستوى المبادئ والقِيَم العقائديّة.
(ورائدة) ؛ لأنّها مهّدت لروح ثوريّة، وثورة روحيّة انطوت عليها صدور المسلمين تذكّرهم في نومهم وقعودهم بمعنى الكرامة، وبمعنى أن ينتصب المؤمن كالطود الصلب في وجه موقظي الفتنة باسم الدين، ورافعي مداميك الشرك والعبث في صرح العقيدة. فكانت دعوة جاهرة لنقض هذه المداميك، وهدم دعائم الضلال والوقوف أمام أهداف الذين حادوا عن صراط الشريعة، ولعبوا بنواميس وشرائع الدِّين، وقامروا بكيان الديانة الوليدة، تمهيداً لوأدها قبل أن تحبو.
(ووحيدة) ؛ لأنّها استحوذت على ضمائر المسلمين فيما خلّفته من آثار عقائديّة ضخمة. فما كان قائماً من ممارسات لدى القائمين على الإسلام والحاكمين باسمه، كان بحاجة إلى هزّة انتحاريّة فاجعة لها وَقْع الصاعقة آنذاك، ومسرى الحبّ في الضمائر بعد أجيال وحقب تالية.
(وخالدة) ؛ لأنّها إنسانيّة أوّلاً وآخراً انبثقت عن الإنسان وعادت إليه مجلّلة بالغار، وملطّخة بالدم الزكي، ومطهّرة بزوف الشهادة المُثلى، فظلّت في خاطر المسلم رمزاً للكرامة الدينيّة، شاهد من خلالها صفحة جديدة من مسيرة عقيدته، صفحة بيضاء عارية من أشكال العبوديّة والرّق والزّيف، مسطّرة بأحرف مضيئة تهدي وجدانه إلى السبل القويمة التي يتوجّب عليه السير في مسالكها؛ ليبلغ نقطة الأمان الجديرة به كإنسان.
إذاً هي خالدة؛ لأنّها أخلاقيّة، سنّت دستور أخلاق جديد أضاء للاُمّة الإسلاميّة درب نضالها على مختلف الأصعدة، وعلّمها كيف يكون الجود بالنفس في زمان ومكان الخطر المحيق رخيصاً، وكيف يكون الموت سعادة والحياة مع الظالمين بَرَما، والموت في عزّ خير من حياة في ذُلّ.
تلك كانت مبادئ معلّم الثورة الحسين (عليه السّلام) في ثورته التي فجّرها للإنسان أيّاً كان على وجه هذا الكون، وسجّلها لِتُقال ويُعمل بها في أيّ مكان وزمان برزت فيهما الجاهليّة من الأنفس، واندثرت النزعة السامية التي بشّر بها الأنبياء والمصلحون، والتي ما أنزلت في النفوس إلاّ لتحقيق العدل بين الجميع، ونشر الرحمة والحقّ فيما بينها.
فإذا ما نظرنا إلى هذه الثورة بمنظور اجتماعي ونفساني بحت لوجدنا أنّ ما أسفرت عنه من أخلاقيّات اجتماعيّة لأكثر من أن تحدّ؛ فقد أفلحت النظم التي طوّق بها الاُمويّون مفاسد حكمهم في أن تقف حائلاً بين المسلم والثورة على هذه النظم والأساليب. ويوماً بعد يوم انغرست مبادئ التدجين البشري في النفوس، واستوطنت الحنايا مسلّمات الخنوع والرضا بالمغانم الدنيويّة الزائلة، فنامت ضمائر المسلمين نومة أهل الكهف، واسترخت الهمم الثوريّة التي كانت رمزاً للمسلم في منطلق بعث ديانته، حتّى تحوّل هذا الاسترخاء إلى آفة اجتماعيّة ونفسيّة وغدت تهدّد روح العقيدة.
كانت هذه الآفة تدغدغ من داخل الصدور، وتوسوس ناصحة بالمحافظة على الذوات، والحفاظ على المكاسب المادّية، والمنازل الاجتماعيّة، وتحول دون النضال، فلا يندفع إليه المسلم بحُميا نكرانه لذاته، واستهانته بمكاسبه الزائفة ومنزلته الاجتماعيّة إلى إزالة وضع شاذ اُجبر على السير في ركابه دون أن يدري إلى أيّ منزلق يقوده.
من هذه النقطة التي وصل إليها الإسلام كعقيدة، والمسلم كإنسان انطبعت في سويدائه مبادئها، وجد الحسين (عليه السّلام) بأنّه لا مندوحة من إحداث هزّة توقظ النائمين في أوهامهم، السادرين في ضلالهم، وتقديم بديل حقّ لِمَا كان يسود الاُمّة من مبادئ استسلاميّة. ولمّا تفجّرت هذه الثورة واشتعل أوارها، هتفت للمسلم: قم، لا ترضَ، لا تستسلم، لا توافق على تدجين عقيدتك، لا تبع نفسك التي عمرت بالإيمان لشيطان المطامع، ناضل ولا ترضَ بحياة بلهنية وترف مع الظالمين وهادمي الذوات.
وتردّدت أصداء هذه الصيحات في أودية النفوس التي سكنت إلى الهدم يعمل في داخلها، فهبّت بعد إخلاد دام ربع قرن منذ مقتل أمير المؤمنين (عليه السّلام) وتولّي الأمويين مقاليد الاُمّة، حيث غدا الاضطهاد والظلم وسرقة أموال الاُمّة بديهيّاتٍ مسلّماً بها. هبّت كبركان عاصف محموم، فاقتلعت هذا الرّكام من البديهيّات المتمثّل بالخنوع والزلفى والانهيار البطيء.
والخطأ الفادح الذي يتصوّره اُولئك المتسائلون ردّاً على أسئلتهم. ماذا كان من الممكن أن يغدو الحال لو لم يقم الحسين (عليه السّلام) بثورته؟ وما مصير اُمّة الإسلام إذا ما قدّر للاُمويّين دوام العبث باسم الخلافة؟ يكمن في تصوّرهم الآني لِما كان سيحدث. فقد تصوّر البعض بأن يستمر الحكم الاُموي في سياسته لإغراق جموع
الاُمّة في ماعون الشهوات الذي نَصَبوه لها، فتنحلّ هذه الاُمّة، ويجد الفاتحون فرصة لاكتساح البلاد دون مقاومة، فيتشرّد المسلمون بدداً في الأرض.
إنّ مثل هذا التصورّ برأيي يسيء إلى مفهوم ثورة الحسين (عليه السّلام)؛ لأنّه تصوّر قاصر ينتهي إلى مفهوم سيّئ مادّي بحت ذي أبعاد زمانيّة ومكانيّة محدّدة.
(زمانيّة) تنتهي باكتساح دولة الاُمويّين و (مكانيّة) في قيام دولة غريبة قد تجافي روح الإسلام في بقعة من أرض الشام، أمّا التصوّر فيما ستؤول إليه العقيدة، وما سيكون عليه مصير الاُمّة الدِّيني. فذلك لم يحظَ بأقلّ تصوّر لدى أغلبيّة مَن أرّخوا للثورة أو كتبوا لها.
فالثورة عندما قامت استمدّت عزمها من روحيّة الشريعة، وكانت تهدف إلى إعادة بثّ هذه الروحيّة في نفس كلّ مسلم، ولو كان التصوّر يقف عند حدود إزالة دولة الأمويين لَما عنى الحسين (عليه السّلام) نفسه بهذه الثورة، لكنّه (عليه السّلام) كان عارفاً بأنّه خاسر معركة ليكسب الإسلام الحرب. الحرب على الظلم عامّة، والانتصار على مسبّبات ضعف العقيدة، وأكبر دليل على ذلك أنّه كان بإمكانه (عليه السّلام) أن يلجأ إلى نفس الأساليب التي لجأ إليها خصمه يزيد، فيشتري الأنصار ويبذل المال لشراء الضمائر.
وكان (عليه السّلام) قادر على فعل ذلك، إلاّ أنّه لم يرضَ بهذا الاُسلوب الوقتي. وهذا ما أعلنه في خطابه للذين بايعوه؛ كي تظلّ ثورته صافية، لا يتّهم بأنّه استأجر لها أنصاراً ولأفكاره مؤيّدين، إضافة لكونه (عليه السّلام) كان عارفاً بأنّ ثورته في حساب الخسارة والربح، لا بدّ خاسرة، لكنّه كان يستقرئ المستقبل لربح أعظم يتعلّق بدوام صفاء العقيدة، وإلاّ لكان بإمكانه الاعتصام في شعاب الحجاز وقيادة ثورته من ركن قصي آمن، موفّراً نفسه وأنفس أهل بيته وخلّص أصحابه، ولكن كلّ ذلك لم يكن كافياً لإقناعه (عليه السّلام).
ونقول إقناعه ونحن على فَهْمٍ تامّ بأنّ عدم قناعته كانت تستند إلى وحي إلهي؛ لإتمام المسيرة التي لا بدّ منها لخير الاُمّة.
وبالمقابل كان ثمّة إجماع ممَّن حوله يستدعي البقاء حيث كان ويدعو إلى عدم الخروج من مكّة، والاستعاضة عن الجهاد ببذل النفس بقيادة الثورة من بعيد. فكان أمام الحسين (عليه السّلام) أكثر من بديل للموت، وأكثر من اقتراح للسلامة، وكان (عليه السّلام) عالماً بكلّ هذه البدائل والطرق الموصلة إليها وإلى نقيضاتها، إلاّ أنّ الحكمة الإلهيّة التي كانت تخطّط لثورته أكبر من فهم البشر وأعظم تَجلَّة من أن تدخل في نطاق بصيرتهم، لذا فقد سارت ثورة الحسين (عليه السّلام) كما اُوحي له بها، ونجحت ذلك النجاح القياسي الهائل، والذي لم تكن لتبلغه لو سارت على نهج تقليدي على هَدي ما قدّم من اقتراحات وبدائل.
وذات الوحي الإلهي الذي حدّد مسار وتوقيت ثورة الحسين (عليه السّلام) أزال الغشاوة عن العيون وبدّد الأوهام التي رانت على العقول والضمائر والتي ظنّت ساعة قيام الثورة بأنّها كانت لمناوئة حكم الاُمويين، وبأنّها ستنطفئ بانطفاء جذوتها وتخمد بانخماد شراراتها المشتعلة. فعرفت هذه العقول وقنعت هذه البصائر بأنّ ثورة الحسين (عليه السّلام) كانت يقيناً ربض في أعماق الصدور، ووحياً استلهمه كلّ مظلوم على مرّ الأجيال والقرون وعلى اختلاف البشر ونحلهم ومللهم، وإنّها كانت نبراساً يضيء للناس، وحرارة تستعر في قلوب المؤمنين.
ألم يقل رسول الله (صلّى الله عليه وآله): «إنّ لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبداً»؟! أمَا خطر لاُولئك الذين شرحوا ثورة الحسين (عليه السّلام) بأنّها حركة رجل ضدّ رجل بعد اختلاف على الحكم والمبادئ، كي يستلهموا كلمات صلوات الله عليه ويستنبطوا معانيها الجليلة الخالدة؟ أمَا خطر لهم أن يتساءلوا: ولِمَ يظل لقتل الحسين تلك الحرارة التي لا تبرد أبداً في قلوب المؤمنين ما دامت حركة زمنيّة مؤقّتة لا انتفاضة روحيّة عقائديّة، جعلت القيم الدينيّة والشريعة محل اهتمامها، والإنسانيّة محور وسائلها والحقّ مطلبها؟
واُولئك الذين نظروا إلى حركة الحسين بكثير من قصر النظر، وأيضاً الذين أرّخوا لها وكتبوا عنها، ألم يلفت نظرهم أنّ هذه الثورة لا يجوز أخذها بمأخذ الثورات التقليديّة؟ كي يعلموا أنّها كانت صراعاً بين خُلقين ومبدأين، وجولة من جولات الصراع بين الخير والشر، بين أنبل ما في الإنسان وأوضع ما يمكن أن تنحدر إليه النفس البشريّة من مساوئ؟
ألم يعوا كيف تحوّلت هذه الملحمة العظيمة بتقادم العهد عليها إلى مسيرة؟ وكيف صارت الشهادة التي أقدم عليها الحسين (عليه السّلام) وآل بيته وصحبه الأطهار، إلى رمز للحق والعدل؟ وكيف صار الذبيح بأرض كربلاء، منارة لا تنطفئ لكلّ متطلّع باحث عن الكرامة التي خصّ بها سبحانه وتعالى خلقه بقوله:( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ) ؟
والسيرة العطرة لحياة سيّد شباب أهل الجنّة، واستشهاده الذي لم يسجّل التاريخ شبيهاً له كانا عنواناً صريحاً لقيمة الثبات على المبدأ، وعظمة المثالية في أخذ العقيدة وتمثّلها، فغدا حبّه كثائر واجباً علينا كبشر، وحبّه كشهيد جزءاً من نفثات ضمائرنا، فقد كان (عليه السّلام) شمعة الإسلام أضاءت ممثّلة ضمير الأديان إلى أبد الدهور، وكان درعاً حمى العقيدة من أذى منتهكيها، وذبّ عنها خطر الاضمحلال، وكان انطفاؤه فوق أرض كربلاء مرحلة اُولى لاشتعالٍ أبدي، كمثل التوهّج من الانطفاء، والحياة في موت.
فلو كان فرخ النبي (عليه السّلام) ضنيناً بمبدأ، ولو لم تكن له عقليّة متصوّرة موحى لها لَما استطاع أن يفلت من ربقة الأطماع التي كانت بمثابة دين ثانٍ في ذلك العهد، ولَما كان ارتفع بنُبلٍ قلّ نظيره فوق الدوّامة التي دوّمت الجميع، اُولئك المتزلّفين، يزيد على خطى مَن سبقهم في تزلّف والده معاوية.
كان (عليه السّلام) لو شاء لأصبح - بانحناءة رأس بسيطة - أميراً مطلقاً على ولاية ما، أو يقنع بزعامة شيعة أبيه (عليه السّلام)، بينما تنتهك حرمات الدِّين على يد أمير مؤمنين مزيّف.
لكنّه لم يؤثر السلامة، ولم يرنُ إلى تطلّعات أرضيّة، فقد كان هدفه أعظم، ورسالته أعمق غوراً وأبعد فهماً لعقليّة الإنسان آنذاك.
كان يريد أن يقول: ما دامت السنّة قد نزلت، وما دام الإسلام وليداً يحبو، فما على المسلم إلاّ أن يكون حفيظ سنّته، وراعي عقيدته، لا من أجله فحسب، بل من أجل كلّ مَن سيولد في الأحقاب التالية على هذه السنّة.
فجاءت صيحته نبراساً لبني الإنسان في كلّ عصر ومصر، وتحت أيّة عقيدة انضوى، إذ إنّ أهداف الأديان هي المحبّة والتمسّك بالفضائل، لتنظيم علاقة الفرد بربّه أوّلاً، وبأخيه ثانياً.
فلعمري أيّة ثورة تقوم على الحق القراح الخالي من أغراض الهوى، ولا تجد لها سبيلاً إلى المهج والحنايا! ألم تكن دعوة الحسين (عليه السّلام) دعوة للتفريق بين الحقّ والباطل؟ أمَا قيل اعجاباً بهذه الثورة: إنّ الإسلام بدؤه محمّدي وبقاؤه حسيني؟
ولنطرح جانباً آراء اُولئك الذين رأوا في حركة الحسين (عليه السّلام) حركة عاطفيّة بحتة، ألقى فيها الشهيد المقدّس بنفسه وآل بيته وصحبه الأطهار في معركة كانت معروفة النتائج سلفاً، والتي تمثّلت بوقوف ثلاثة وسبعين مقاتلاً في مواجهة خمسين ألف مقاتل.. فتلك الآراء إنّما تمثّل الجانب الفكري ناقص النضج، والذي وضع حركة الحسين (عليه السّلام) في إطار الثورة للثورة ولا شيء عداها. ولم ينظر إليها ما هي وكما هدفت إليه كمنعطف خطير لمسيرة العقيدة الإسلاميّة، والتي لولاها لَما كان وجد المؤرّخون شيئاً يتحدّثون به عن الإسلام.
ولعلّ خير مَن وصف هذه الثورة كان ماربين الألماني في كتابه (السياسة الإسلاميّة) إذ قال: إنّ حركة الحسين في خروجه على يزيد إنّما كانت عزمة قلب كبير عزّ عليه الإذعان وعزّ عليه النصر العاجل، فخرج بأهله وذويه ذلك الخروج الذي يبلغ به النصر الآجل بعد موته، ويحيي به قضيّةً مخذولةً ليس لها بغير ذلك حياة(1) .
من هذا الفهم يتّضح أنّ قضيّة السنّة الإسلاميّة كانت قضيّة مخذولة عندما قام الحسين (عليه السّلام) بثورته، وما كان له محيص من السير بها بالشكل الذي بدت به، غير ضانٍّ بنفسه وبأنفس أهل بيته وصحبه الأطهار؛ لعلمه الأكيد بأنّ ثورته وإن كانت ضعيفة بتركيبتها الماديّة، إلاّ أنّ لها صلابة الصّخر والمبدأ بتركيبتها الروحيّة والرمزيّة، وأنّه بالِغ بها النصر والاستمرار للعقيدة، ما لم يكن ليبلغه بإيثار السلامة من مذبحة كربلاء.
والحسين (عليه السّلام) عندما ثار لم يثَر لأجل نوال كرسي الحكم إذ لم تكن منطلقاته من قاعدة فرديّة أو زمنيّة، بل كانت أهدافها تتعدّاه إلى الأعقاب والأجيال القادمة، التي ستعرف كيف كان شكل الفداء دفاعاً عن عقيدة سُلِّمت لها متلألئة. إنّها عقيدة الشهداء البررة التي لا تنخدع بسراب المطامع الدنيويّة، ولا ترضى بمبدأ المساومة في ميدان العقيدة.
ورفض الخداع والمساومة مقرون دوماً بالاستعداد لبذل الحياة وإطفاء شعلة النفس إذا كان في إطفائها ما ينير شمعة تهدي السائرين على طريق الحقّ والعدل.
وهذا المبدأ المنبثق عن هكذا عقيدة من الصعب إدراك معانيه في أوانه، سيّما إذا
____________________
(1) السياسة الإسلاميّة - ماربين / 213.
كانت الموازين آنذاك هي الموازين التي نَصّبها حكّام ظالمون لاُمّة تدجّنت روحها، وذبلت عقيدتها، فما عادت تفرّق بين الخطأ والصواب.
وعلى هذا المقياس الذي لا يرفعه إلاّ الصّفوة المختارة من الصالحين أصاب الحسين (عليه السّلام) بثورته في المدى البعيد، وأخفق في المدى القريب، طلب إحقاق الحقّ في وقته، فلم يصل إليه، لكن اُمّة الإسلام أدركته بمماته، ولم يقف الأمر عندها على مستوى إدراكه فحسب، بل صار جزءاً من وجدانها العقائدي، وضميراً يستصرخها ويستحثّها في كلّ مواقف الضعف، وحيال مختلف أشكال التدجين والظلم والانحراف عن السّنة.
فداء الحسين (عليه السّلام) في الفكر المسيحيّ
الملحمة التي تمّت فصولها فوق أرض كربلاء، هل هي ملحمة تخصّ فئةً بشريةً ما، أو فئات تعتقد أنّها قامت لأجلها فحسب؟ وهل تعتبر النتائج التي تمخّضت عنها ذات خصوصيّة لهذه الفئة أو تلك، وأنّه لا يمكن لفئات أخرى من استلهام ما قدّمته هذه الثورة وتطبيق أخلاقيّاتها على ممارسات ومواقف أي فرد إنساني ضمن إطار عقيدته وإزاء ممارسات ومواقف حكّامه ومحكوميه؟ وبمعنى أدق هل نرضى بحصر استشهاد الحسين (عليه السّلام) بأرض كربلاء إذا ما رغبنا بوضعها في مكانها حيث جرت أحداثها وكذلك نخصّ بها اُمّة الإسلام على اعتبار أنّها قامت من أجل حماية عقيدة الإسلام، ونتحدّث عنها في صيغة الماضي في الفترة الزمنيّة التي تفجّرت بها؟
تلك التساؤلات تستلزم تحديد ماهيّة ثورة الحسين (عليه السّلام)، هل هي ثورة أرض؟
أم هي انتفاضة على الحكم؟ أم حركة تقويميّة دينيّة؟ أم خطأ في الحركة والتوقيت؟ أم قضيّة خذلان بعد وثوق؟
فلو نظرنا إلى الملحمة على أنّها ثورة تمّت فوق أرض معيّنة هي أرض كربلاء، لجاءنا جواب: على أنّ أيّة بقعة فوق الكرة الأرضيّة من الممكن أن تكون كربلاء ثانية ما دامت واقعة بين مكانين، أحدهما يرتع به الباطل، والآخر ينطلق منه الحق.
وإذا اعتبرت انتفاضة على الحكم، لجاءنا جواب: بأنّها لا تزال مستمرّة حتّى وقتنا هذا في أيّ بلاد فسد بها الحكم.
أمّا القول: بأنّها حركة تقويميّة دينيّة، فإنّها تكون حركة حارّة لم تبرد إلى عصرنا هذا، طالما استغلّ الدين لتحقيق أغراض بعيدة عن جوهره.
وأمام الرأي القائل بأنّها خطأ في الحركة والتوقيت، فإنّ هذا الخطأ يحمل في ثناياه الصواب أكثر ممّا يحمل الصواب من صوابية. أمّا كونها قضيّة خذلان بعد وثوق، فإنّها وإن تك كذلك، فإنّها كانت لحكمة ربّانية من الكفر إثارة التساؤل حولها.
إذاً فإنّ الثورة بماهيّتها هذه ذات استمراريّة خالدة، فكلّ مكان يقف عليه ثائر هنا وهناك هو كربلاء، وكلّ طعنة سيف في عاشوراء هي طعنة لمفاسد الحكم في أيّ وقت، وكلّ نقطة دم أريقت فداءً للحق استمرّت تعلن فداءها في رغبة الإنسان العامرة في الاستشهاد في سبيل مبادئه.
هي ثورة بدأت ساخنة واستمرّت محافظة على سخونتها طالما ثمّة ظلم فوق هذا الكوكب، ولطالما ثمّة فساد في الحكم، ولطالما ثمّة عبث في العقائد. وهي ثورة لن تبرد أبداً، بل هي في غليان دائب سيّما في هذا العصر، عصر الضنك والظلم والاضطهاد والترويع لشعوب كثيرة. حيث انتهكت الحريات، وبان جليّاً العبث في العقائد والأديان، بل واستغلال هذه الأديان في تثبيت المفاسد والانتهاكات البشريّة.
فالحسين (عليه السّلام) ثار من أجل الحقّ، والحق لكلّ الشعوب.
والحسين (عليه السّلام) ثار من أجل مرضاة الله، وما دام الله خالق الجميع، فكذلك ثورة الحسين لا تختصّ بأحدٍ معيّن، بل هي لكلّ خلق الله.
وفي قولة النبي الكريم: «إنّ لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبداً». دلالة على شموليّة ثورة الحسين (عليه السّلام)، فمقولة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لم تقتصر على (المسلمين)، وإلاّ للفظها لسانه الكريم بهذا المعنى... لكنه (صلّى الله عليه وآله) شمل كلّ المؤمنين قاطبةً تحت أية عقيدة انضووا، وفوق أية بقعة فوق الأرض وجِدوا، وخصّهم بنصيب من هذه الحرارة السّنية التي لا تبرد في قلوبهم لقتل الحسين.
المظلومون والمضطهدون والمقهورون والمروّعون من كلّ المذاهب والبقاع يتّجهون في كلّ رغباتهم إلى جوهر ثورة الحسين (عليه السّلام)، ففي اتجاههم الفطري ورود إلى منبع الكرامة والإنصاف والعدل والأمان.
وما دامت قد تحدّدت ماهيّة ثورة الحسين (عليه السّلام) بهذه الأطر، أفلا يجدر اعتبار الحسين شهيداً للإسلام والمسيحيّة واليهوديّة ولكلّ الأديان والعقائد الإنسانيّة الاُخرى؟
فإذا كان من البديهي الإجابة بـ(نعم) فما هي إذاً رؤية الفكر المسيحي المتفرّع من شجرة الفكر الإنساني لملحمة استشهاد وفداء الحسين (عليه السّلام)، هذا الفكر الذي يرى في ركني الاستشهاد والفداء الأعمدة التي تقوم عليها معتقداته المؤطّرة بشمولية إنسانيّة؟
فعيسى بن مريم (عليه السّلام) ما جاء إلى الناس إلاّ فادياً ومستشهداً من أجل بشارة الحقّ(1) . وثمّة تقارب كبير بين حركتي الفداء والاستشهاد الّلتين أقدم عليهما عيسى والحسين (عليهما السّلام)، مع الإقرار بالفوارق البيّنة في أسبابهما وكيفيّتهما، لا في جوهرهما وأهدافهما.
فأوجه الشبه بين عيسى والحسين (عليهما السّلام) تتجلّى في مولدهما وسيرة حياتهما، فقيل: لَم يولد مولود لستّة أشهر وعاش إلاّ الحسين وعيسى بن مريم.
واعتلّت فاطمة (عليها السّلام) لمّا ولدت الحسين (عليه السّلام) وجفّ لبنها، فطلب رسول الله مرضعة فلم يجد، فكان يأتيه فيلقمه إبهامه فيمصّه، ويجعل الله في إبهام رسوله غذاء الطفل الوليد، ففعل ذلك أربعين يوماً بلياليها، فأنبت الله سبحانه وتعالى لحمه من لحم رسول الله(2) ، وهذا ما يفسّر قول الرسول الكريم: «حسين منّي وأنا من حسين». وهكذا كان الحسين الرضيع غذيّ النبوّة، وعيسى مولود النفحة السماويّة بمريم (عليها السّلام)، غذيّ القوّة الإلهيّة.
قسيس مسيحي قال: لو كان الحسين لنا لرفعنا له في كلّ بلد بيرقاً، ولنصبنا له في كلّ قرية منبراً، ولدعونا الناس إلى المسيحيّة باسم الحسين.
____________________
(1) يوحنا 14 / 6.
(2) أبو الشهداء - العقّاد / 54.
مثل هذا الكلام لا يصدر على عواهنه، بل يقصد به أنّ الفداء والاستشهاد اللذَين يشكّلان ركن الدين المسيحي الأساسي قد جسّدهما الحسين (عليه السّلام) خير تجسيد في استشهاده، هذا الاستشهاد الذي لا يقدم عليه إلاّ المبشّرون بالأديان السماويّة، أو المتصدّون لانحرافها، وكان الحسين (عليه السّلام) واحداً منهم.
ولنعد إلى نقاط التشابه والاختلاف بين الشهيدَين العظيمَين للإسلام والمسيحيّة، فنجد أنّهما - حتّى في اختلافهما في بعض نقاط - ثمّة تشابه غير مباشر يقرّبهما من بعضهما، فعيسى (عليه السّلام) اُوتي قدرة مخاطبة الناس وهو في المهد صبيّا، والحسين (عليه السّلام) اُوتي ملكة الخطابة من طلاقة لسان، وحسن بيان، وغنّة صوت، ورشاقة إيماء.
وعيسى اضطهد واُهين وضفر جبينه بالشوك، وحوكم وقُتل، وطُعن وبصق عليه، وجرّد من ثيابه. والحسين شرّد وحوصر، واُعطش واُهين، وقُتل وسبيت عياله، وجرّد من ثيابه وسلبت حلله.
عيسى (عليه السّلام) قال: «روح الربّ نازل عليَّ؛ لأنّه مسحني وأرسلني لاُبشّر الفقراء، واُبلّغ المأسورين إطلاق سبيلهم، واُفرّج عن المظلومين، وأعلن سنّة مرضيّة لدى الربّ»(1) . والحسين (عليه السّلام) قال:
____________________
(1) لوقا 4 / 18 - 19 و أشعيا 61 / 1 - 2 و متّي 3 / 16.
«وإنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً، ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في اُمّة جدّي، اُريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدّي وأبي علي أبي طالب».
عيسى قال لتلاميذه: «فإذا اضطهدوني يضطهدونكم أيضاً، سينزلون بكم ذلك كلّه من أجل اسمي، لو لم آتِ واُكلّمهم لما كتبت عليهم خطيئة»(1) . والحسين قال لصحبه قبل بدء المعركة عشيّة التاسع من محرّم: «إنّي لا أعلم أصحاباً أولى ولا خيراً من أصحابي، ولا أهل بيت أبرّ وأوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عنّي جميعاً. ألا وإنّي أظنّ يومنا من هؤلاء غداً، وإنّي قد رأيت لكم فانطلقوا جميعاً في حلّ ليس عليكم منّي ذمام، وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملاً، وليأخذ كلّ رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، فجزاكم الله جميعاً خيراً، وتفرّقوا في سوادكم ومدائنكم؛ فإنّ القوم إنّما يطلبوني، ولو أصابوني لذهلوا عن طلب غيري»(2) .
عيسى (عليه السّلام) أنكره أقرب تلامذته (بطرس)، والحسين (عليه السّلام) خذله أنصاره الذين استدعوه من المدينة.
____________________
(1) يوحنا 15 / 21 - 22.
(2) الطبري 6 / 238 - 239، والكامل لابن الأثير 4 / 34.
عيسى اقتُسمت ثيابه بعد موته إلى أربعة أنصباء لكلّ جندي نصيب، وأخذوا القميص أيضاً وكان غير مخيط منسوجاً كلّه من أعلاه إلى أسفله، فقال بعضهم لبعض: لا ينبغي أن نشقّه، بل نقترع عليه فنرى لمَن يكون(1) . والحسين لحقته هذه الإهانة وهو صريع متضرّج بدمائه في فلاة كربلاء، فسلبه قاتلوه، ولم يوفّروا حتّى تكّة سرواله، وامتدّت لها يد أحدهم بلا أدنى استعظام أو تأثّم(2) .
ابن مريم مات عطشان، ففي لحظات نزاعه الأخير هتف: (أنا عطشان)(3) فلم يؤتَ له بماء، بل كان هناك إناء مليء خلاًّ، فوضعوا اسفنجة مبتلّة بالخلّ على قضيب من الزّوفي وأدنوها من فيه فلمّا ذاق الخلّ لفظ روحه. وابن فاطمة وهو مجندل مطعون في ترقوته ونحره وجنبه وحلقه ورأسه وجبهته وقفاه والدم ينبع ويخضّب جسده الطاهر ويلوّن شيبته المقدّسه، وكان في نزاعه الأخير حينما استقى ماء فأبوا أن يسقوه، وقال له رجل: لا تذوق الماء حتى ترد الحامية فتشرب من حميمها(4) .
والأنبياء والشهداء والمصطفون يدركون أنّ وجودهم المادّي زائل، لكن حججهم ونفثات ضمائرهم هي التي ستبقى لتسري في النفوس مسرى النار في الهشيم، وليتردّد صداها في المهج، فلا يهدأ لها صدى إلاّ ليرجع من مكان
____________________
(1) يوحنا 19 / 24.
(2) راجع اللهوف / 73، ومقتل الخوارزمي 2 / 38، وكامل ابن الأثير 4 / 32، ومناقب ابن شهر آشوب 2 / 224، ومقتل الخوارزمي 2 / 102.
(3) يوحنا 19 / 29 - 30.
(4) ابن نما / 39.
آخر، وهكذا فبينما يحيط جند يزيد بالحسين (عليه السّلام) إذ به يعتلي راحلته ويخاطبهم: «أيّها الناس، انسبوني مَن أنا، ثمّ ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها وانظروا: هل يحلّ لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيّكم، وابن وصيّه، وابن عمّه، وأوّل المؤمنين بالله، والمصدّق لرسوله بما جاء من عند ربه؟ أو ليس حمزة سيّد الشهداء عمّ أبي؟ أو ليس جعفر الطيّار عمّي؟ أو لم يبلغكم قول رسول الله لي ولأخي: هذان سيّدا شباب أهل الجنة؟».
فقال الشمر: هو يعبد الله على حرف إن كان يدري ما يقول. ثمّ قال الحسين (عليه السّلام): «فإن كنتم في شكّ من هذا القول، أفتشكّون أنّي ابن بنت نبيّكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبيّ غيري فيكم ولا في غيركم. ويحكم! أتطلبوني بقتيل منكم قتلته أو مالٍ لكم استهلكته أو بقصاص جراحة؟»(1) . فأخذوا لا يكلّمونه، وأصمّوا آذانهم عن سماع حديثه، فقد تفاعل الحقد في عروقهم فأعماهم عن صوت الحقّ الذي ينطق به لسان سيّد الشهداء.
فسبحان الذي رسم لشهدائه وأبراره مثل هذه المواقف! الشهيد والنبي والمصلح يقفون أمام الفاسدين يستعطفون قلوباً تحجّرت وأبت إلاّ أن تقف إزاءهم بنفوس ملؤها الشرّ والحقد، وهذا ما فعله أعداء الحسين (عليه السّلام) الذين التفّوا حوله هازئين مستعدّين للانقضاض عليه بعد وقت قصير باسم دين جدّه المصطفى، فكان حالهم كحال مَن يحارب البياض باسم السّوسن، وكحال مَن عنتهم تلك الآية الكريمة التي جرت على لسان المسيح: «سماعاً تسمعون ولا
____________________
(1) رواه ابن نما في مثير الأحزان / 26، وجاء في تاريخ الطبري 6 / 243.
تفهمون، ونظراً تنظرون ولا تبصرون. فإنّ قلب هذا الشعب قد غلظ، لقد ثقّلوا آذانهم، وأغمضوا عيونهم لكي لا يبصروا بعيونهم، ولا يسمعوا بآذانهم، ولا يفهموا بقلوبهم»(1) .
وكما سيّد الشهداء كذلك عيسى رسول السّلام والمحبّة وقف في مثل وقفته بين اليهود الذين جاؤوا لاعتقاله، فقال مخاطباً الأحبار وقادة الحرس والشيوخ: «أعلى لصٍّ خرجتم تحملون السيوف والعصي؟ كنت كلّ يوم بينكم في الهيكل فلم تبسطوا أيديكم إليَّ، ولكن تلك ساعتكم، وهذا سلطان الظلام»(2) .
وقال أيضاً: «ألم يعطكم موسى الشريعة وما من أحد منكم يعمل بأحكام الشريعة؟ لماذا تريدون قتلي؟»(3) . فأجابه الجمع كما أجاب الشمر الحسين: بك مس من الشيطان)(4) . قال عيسى: «لماذا لا تفهمون أقوالي؛ لأنّكم لا تطيقون الاستماع إلى كلامي. إنّكم أولاد أبيكم إبليس، لم يثبت على الحقّ؛ لأنّه ليس فيه شيء من الحقّ؛ لأنّه كذّاب وأبو الكذّاب. أمّا أنا فلا تصدّقوني؛ لأنّني أقول الحقّ، أنا أعلم أنّكم ذرّيّة إبراهيم، ولكنكم تريدون قتلي»(5) .
صيحتان متشابهتان أطلقهما وسط غلاظ القلوب، رسول المحبّة، وسيّد الشهداء (عليه السّلام)،
____________________
(1) متّي 13 / 15، رسل 28 / 26.
(2) لوقا 22 / 52 - 53 - 54.
(3) يوحنا 7 / 19.
(4) راجع الفقرة 20 من إنجيل يوحنا 7، يجيب المسيح: (ما عملت إلاّ عملاً واحداً فتعجّبتم كلكم).
(5) يوحنا 8 / 43 - 44 - 46.
وأمام الموت المحيق بهما، إنّها ضريبة الحق قبل أن تُؤدّى.
كان بإمكان الشهيدَين تجنّب هذا الموقف وهذا الكلام، لكنّهما أدّيا واجب الكلمة الحقّة قبل أن يؤدّيا واجب الشهادة، بثّا في الضمائر بذرة الخير تعمل بها وتتفاعل لتنشر عبقها في الهواء، فتعمّ الجميع وتفيء بظلّ حقّها على القلوب، وتكون الجرثومة التي تقتل ما فسد من أخلاق ونفوس والترياق المحيي للصدور المسمّمة، والمهج المشرفة على الاختناق بضلالها.
وحكمة الله تنفح الرؤى في رؤوس الأخيار البررة، فتجري على ألسنتهم كلاماً يحمل معنى النبوءة، ففي موقع الخطر وفوق أرض النهاية حيث تُتعتع أشدّ العقول رباطة، وتتزعزع أقوى القلوب جأشاً، تظلّ قلوب الشهداء حيّة، وعقولهم صافية منيرة.
ففي حومة الخطر خاطب الحسين (عليه السّلام) قاتليه بما سيحلّ بهم وما أثبتته الأيّام بالصدق، وصوّر لأعينهم وبصائرهم أي منقلبٍ سينقلبون إذا ما أقدموا على قتله؛ وذلك كي يكون في كلامه عظةٌ وإنذارٌ قبل الوقوع في الخطأ، علّهم يرعوون ويتوبون إلى ربّهم وضمائرهم. ولكن هيهات للضمائر التي نامت، وللنفوس التي هرمت أن تعي عظة مقدّسة حيّة، فلو وعت لقدّمت المُثل الحيّة على مفاسد الأخلاق وموت الضمائر، ولارعوت بما قاله سبط النبي (عليه السّلام): «أما والله لا تلبثون بعدها إلاّ كريثما يركب الفرس، حتّى تدور بكم دور الرحى، وتقلق بكم قلق المحور، عهدٌ عهده إليَّ أبي عن جدّي رسول الله. فاجمعوا أمركم وشركاءكم، ثمّ لا يكن أمركم عليكم غمّة، ثمّ اقضوا إليَّ ولا تنظرون إنّي توكّلت على الله ربّي وربّكم ما من دابّة إلاّ هو آخذ بناصيتها إنّ ربّي على صراط
مستقيم»(1) . ثمّ رفع يدَيه نحو السماء وقال: «اللّهمّ احبس عنهم قطر السماء، وابعث عليهم سنين كسنيّ يوسف، وسلّط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأساً مصبّرة؛ فإنّهم كذّبونا وخذلونا وأنت ربّنا عليك توكّلنا وإليك المصير. والله لا يدع أحداً منهم إلاّ انتقم لي منه قتلة بقتلة، وضربة بضربة، وإنّه لينتصر لي ولأهل بيتي وأشياعي»(2) .
ويقابل هذا القول ذلك الذي جرى قبل قرون على لسان شهيد المسيحيّة حينما حكم عليه علماء الشريعة اليهوديّة بالموت، إذ قال مخاطباً إيّاهم: «الويل لكم أنتم يا علماء الشريعة! تُحمّلون الناس أحمالاً باهظة وأنتم لا تمسّون هذه الأحمال بإحدى أصابعكم! الويل لكم! تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم! فأنتم الشهود، وأنتم على أعمال آبائكم توافقون، هم قتلوهم وأنتم تبنون؛ ولذلك قالت حكمة الله: أرسل إليهم الأنبياء والرسل وسيقتلون منهم ويضطهدون حتّى يطلب من هذا الجيل دم جميع الأنبياء الذي سفك منذ إنشاء العالم، من دم هابيل إلى دم زكريّا الذي قتل بين المذبح والهيكل»(3) .
فإيراد مثل هذا التشابه في الأقوال والمواقف والمصير بين الشهيدَين عيسى والحسين (عليه السّلام) من شأنه إبراز نواحي عنصر الشهادة بينهما رغم أنّهما جاءا في عصرين مختلفَين، وأدّيا رسالتَين مختلفتَين في الشكل، متجانستَين في المرمى.
فعيسى بن مريم (عليه السّلام) جاء إلى اليهود يحمل رسالة جديدة يبشّر بها هي اتمام
____________________
(1) تاريخ ابن عساكر 4 / 334، ومقتل الحسين (عليه السّلام) للخوارزمي 2 / 7، واللهوف / 54.
(2) اللهوف / 56 طبعة صيدا، ومقتل الحسين (عليه السّلام) للخوارزمي 2 / 7، ومقتل العوالم / 84.
(3) لوقا 11 / 46 - 51.
لرسالة العهد القديم التي حرّفها اليهود ووضعوا لها شريعة أسمَوها شريعة الآباء، فاضطهدوه واتّهموه بما لا يتّهم به نبي. ثمّ قدّموه للموت، فتقدّم إليه كهدف أنفذ لأجله، وقد فدى نفسه وحدها لتظلّ رمزاً للمسيحيين من بعده تذكّرهم بمعنى افتداء نفس قرباناً للعقيدة، فيحسّون بضعفهم إذا ما ضعفت عقيدتهم، وتكون مناسبة الفصح مناسبة للحزن والذكرى، وإعادة التبصّر، وتقويم الضعف في النفوس، والانحراف في أخذ العقيدة.
وبمقياس الجود بالنفس الواحدة مقابل سلامة العقيدة أو بعثها من البدء، فإنّ الأنبياء موسى وعيسى ومحمّد (عليهم السّلام) والشهداء زكريّا ويحيى وعلي والحسن والحسين والعبّاس وغيرهم.. أدّوا رسالتهم الكاملة بما يرضي الله سبحانه تعالى كما رسمها لهم، وكانت أنفسهم الطاهرة هي القربان الذي قدّموه على مذبح الشهادة.
فإذا كانت الأديان السماويّة تنزل ويفدى لها بنفس رسولها، وتنشر فيفدى لها بنفس ناشرها، وتحمى فيفدى لها بنفس حاميها، فبأي وصف أو مقياس يمكن لنا ولأجيال المؤمنين من بعدنا أن نقيس ثورة الحسين (عليه السّلام) التي قدّم فيها عترة آل البيت وصحبه الأخيار، وكان ثمن دفاعه عن انحراف العقيدة ثلاثاً وسبعين نفساً طاهرة هي اُسرة النبي الذي أنزلت الرسالة به، والتي حارب أعداء الرسالة سبطه باسم رسالته.. سبطه الذي قال عنه (صلّى الله عليه وآله): «حسين منّي وأنا من حسين»(1) ؟ هل يمكن قياسها بمقياس ما قدّمت، أم بمقياس ما زالت تقدّمه؟
____________________
(1) تعبير رواه من الإماميّة ابن قولويه في كامل الزيارات / 53، ومن أهل السّنة الترمذي في جامعه في مناقب الحسين، والحاكم في المستدرك 3 / 177، وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق 4 / 314، وابن حجر في مجمع الزوائد 9 / 181، والهيتمي في الصواعق المحرقة / 115 حديث 23، والبخاري في الأدب المفرد، والمتقي الهندي في كنز العمال 7 / 107، والصفوري في نزهة المجالس / 478، وأمالي السيّد المرتضى 1 / 157 المجلس الخامس عشر (نقلاً عن المقرم).
إذا قسناها بالمقياسين - ولا مندوحة لنا إلاّ بهما - فنجد أنّ ثورة ريحانة النّبي هي أعظم الثورات قاطبة، وشهادته متممّة لكلّ الشهادات التي سبقتها، إذ إنّ هذه الثورة قَبِلت قرباناً لها الشيخ والمرأة والطفل والرضيع. وكانوا كلّهم في ميدان واحد مشاهدي مجزرة ومتحمّلي نتائجها. فهي ثورة جعلت من مشعل أوارها وارث آدم صفوة الله، ووارث نوح نبي الله، ووارث إبراهيم خليل الله، ووارث عيسى روح الله، ووارث محمّد حبيب الله.
واستشهاد الحسين بهذا الشكل الدراماتيكي المؤلم رفعه مرتبة فوق الشهداء فصار سيّدهم ومعلّمهم، سيّما إذا نظرنا إلى الوسائل والكيفيّة التي تمّت بها شهادته مختتماً بها ثورته المنتصرة رغم خذلانها.
ففي الهدف ثبت أنّ ثورة الإمام كانت دفاعاً عن كلّ الرسالات السماويّة التي سبقتها ما دام هدف الرسالات تقديم المثال الحي على خلودها بالاستشهاد المعمَّد بالدم، و هو (عليه السّلام) تمّم بها ما بدأه جميع الأنبياء الذين ذاقوا الاستشهاد حرقاً وقتلاً وذبحاً وصلباً.
وفي الكيفيّة والوسيلة نرى أن ليس ثمّة ثورة تشبه ثورة الحسين بكيفيّتها ووسائلها، فقد كان سبط النبي (عليه السّلام) مصلحاً كبيراً انبثق من جموع الاُمّة، وله صفة بشريّة واحدة لا صفة رسوليّة كما للرسل، فكان عليه أن يسلك في كفاحه مسلك البشر المعذّبين والمحاصرين، ويلجأ إلى الوسائل البشريّة المحدودة في صراعه المستميت ضدّ حاكم غاشم وسلطة فاسدة منكّلة تبغي الانحراف بالعقيدة تحت لوائها.
وكانت المهمّة الملقاة على عاتق سيّد الشهداء غاية في الصعوبة؛ فقد كان الإسلام وليداً لمّا يزل يحبو، وقد اجتاز فترة مولده وفتوحاته الاُولى، واسترخت الاُمّة الإسلاميّة بعدها، ودبّ الخلاف في أوساطها، وصارت الأطماع الدنيويّة هي المحكّ لنفسيّة المسلم آنذاك، بعد أن نجحت سياسة الاُمويّين في تدجين الاُمّة
وتركيعها، وإقامة خلافة كسرويّة مدعومة بارستقراطيّة وثنيّة محرّفة ناصبت القائمين على الإسلام العداء، التي نجح الرسول (صلّى الله عليه وآله) في القضاء عليها في حياته؛ لأنّها انضوت تحت لواء الإسلام واعتنقت العقيدة سعياً وراء مصالحها الشخصيّة، وما كان أكثرها.
من هنا كانت صعوبة المهمّة التي أخذها الحسين على عاتقه، وهي النهوض باُمّة الإسلام من خدرها وإعادتها إلى الصراط المستقيم الذي بشّر به جدّه الكريم، صعوبة لا يحسّها إلاّ مَن كان في وضع مثل وضع الحسين يعتمد على مناصرين تفتّتوا بدداً، كما لو أنّهم لم يكونوا، وكأنّهم لم يرسلوا كتبهم في طلبه من المدينة ليقودهم في حركته، في مقابل حكم طاغ له من عدده وعدّته الشيء الكثير، مدعوماً بقوى غاشمة، بينما لا تلفت مفاسده انتباه قوى استطاع شراء سكوتها بالمال، بينما البقيّة التي كانت تحسّ الظلم والضنك آثرت السكوت والخنوع؛ إمّا حفاظاً على مكاسب رخيصة، أو خوفاً من بطش اُميّة.
وإذا حاولنا النظر مجدّداً إلى حراجة موقف الحسين في إعلانه عدم البيعة ليزيد وخروجه إلى الكوفة - مع علمه بإمكانيّة خذلانه - لتبيّن لنا بوضوح اُسلوب الحركة عند الحسين (عليه السّلام)، فهو لا يقف ليزن الأمر بميزان القدرة والاقتدار استناداً إلى الإمكانات التي بين يدَيه، وعلى ضوء ما لدى يزيد. كان المبدأ يعتمل في صدره يلحّ عليه بهواتف مجهولة لأن يتقدّم ويجابه دونما خوف من مآلٍ أو نتيجة، فالإقدام والتصدّي لقوى الظلم هما الثمرة التي ستكبر وتكبر إلى أن يحين موعد قطافها.
وإذا كان الأنبياء والرسل قد خصّهم تعالى بقوى وخوارق علويّة أكبر من قدرة البشر فإنّ الحسين (عليه السّلام) حتّى لحظة استشهاده كانت وسائله بشريّة صرفة لا تزيد ولا تنقص، عدا جوهر المبدأ فوق البشري الذي خطّط له حركته.
ولقد أيّد الله تعالى كلّ نبي بمعجزة ممّا هو منتشر في عصره. ففي زمن موسى (عليه السّلام) كان السحر منتشراً كلّ الانتشار، فأيّد الله نبيّه موسى بمعجزة من نفس الشيء المنتشر، فألقى عصاه فإذا هي حيّة تسعى.
وفي زمن عيسى (عليه السّلام) كان الطبّ منتشراً انتشاراً هائلاً، فأيّد الله رسوله عيسى بمعجزة من نفس الشيء المنتشر آنذاك، فأعطاه معجزات إحياء الميّت وإبراء الأكمه والأبرص وطرد الأرواح الشريرة، وهذا إعجاز لم يتوصّل إليه الطبّ في ذلك الوقت ولا في الوقت الحاضر.
وفي زمن محمّد (صلّى الله عليه وآله) كانت الفصاحة والبلاغة هما المرجع الأوّل، وكلّ إنسان يُقدَّر على قَدر فصاحته وبلاغته، فكانت تنظّم القصائد وتعلّق المعلّقات في الكعبة، وتقام الأسواق للمباريات في إلقاء القصائد، فأيّد الله نبيّه محمّداً بلاغة.
وإذا كان حال الأنبياء الذين أيّدهم الله بمعجزات فوق إعجاز البشر قد آلت إلى الاضطهاد والقتل رغم معجزاتهم، فما هو حال الشهيد الحسين الذي لم يؤتَ إعجاز الأنبياء بل كان عليه أن يجاهد كالبشر؟
وليس معنى هذا أنّ الشهيد العظيم لم يكن لدَيه إلاّ الضعف البشري فحسب، بل كانت في صدره جوهرة الشهادة، وكانت له قماشة الشهيد حتّى قبل أن يولد، إذ كان معدّاً لهذه الشهادة وهذا السمو، لكن بوسائل بشريّة؛ كي تتمّ شهادته وتكون لكلّ البشر الذين يقنعون بضعفهم البشري عن القيام بالجهاد، فتكون ثورة سيّد الشهداء هي المثل الحي على إمكانيّة تحويل البشر إلى شبيهي الرسل، بعد أن يحوّلهم المبدأ القوي والعقيدة الثابتة الكامنة في صدورهم إلى ثائرين، يبحثون عن الموت ليلجوا في غمراته غير هيّابين، مبتغين مرضاة الله.
دافعت ثورة الحسين عن السّنة المحمّديّة بقوّة الحجّة، وقوّة الحقّ وبلاغته، ولم تنتصر بقوّة العضلات والأبدان؛ إذ كانت ثورة موجّهة إلى العقول والضمائر والأنفس التي تقدّر للحقّ قدره، وتكره ما للباطل من مساوئ، لقد قال الحسين (عليه السّلام): «أيّها الناس، إنّ رسول الله قال: مَن رأى سلطاناً جائراً؛ مستحلاًّ لحرم الله، ناكثاً لعهد الله، مخالفاً لسنّة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغيّر عليه بفعلٍ ولا قول، كان حقّاً على الله أن يدخله مدخله»(1) .
وقال في خطاب آخر: «ألا ترون إلى الحقّ لا يُعمل به، وإلى الباطل لا يُتناهى عنه؟! ليرغب المؤمن في لقاء الله محقّاً، فإنّي لا أرى الموت إلاّ سعادة، والحياة مع الظالمين إلاّ برما»(2) .
مثل هذا القول لا يصدر إلاّ عن إنسان معدّ للشهادة، ينطق لسانه بما يستقرّ في وحيه من إيحاءات علويّة، إنسان هو بضعة من الرسول الكريم وريحانته، ونفحة من نفحات إلهامه. فعندما ولدت فاطمة حسيناً أخذه النبيّ بين يدَيه وأذّن في اُذنه كما يؤذّن للصلاة، وأفرغ في سريرته الطفوليّة بعضاً من استشرافات النبوّة الهادية للبشر(3) .
إذاً كان الحسين (عليه السّلام) هو رجل المرحلة الثانية للإسلام بعد المرحلة الاُولى التي
____________________
(1) تاريخ الطبري 6 / 229، وكامل ابن الأثير 4 / 21.
(2) اللهوف، والطبري الجزء السادس، والعقد الفريد 2 / 312، وابن عساكر 4 / 333.
(3) أخرج أبو داود والترمذي في (السنن) عن أبي رافع مولى النبي (صلّى الله عليه وآله) قال: رأيت النبي أذّن الحسين حين ولدته فاطمة كما يؤذّن للصلاة. وذكر ابن الصّبان في إسعاف الراغبين: أنّه حنّكه بريقه وأذّن، ودعا له وسمّاه حسيناً يوم السابع، وعقّ عنه. وذكر المفيد في الإرشاد أنّ النبي عقّ عنه كبشاً.
بدأها جدّه الرسول، وكانت مهمّته كبيرة تتصّدى لإعادة مسيرة العقيدة إلى الصراط المستقيم، ولِمَ لا؟! أليس (عليه السّلام) هو خامس أهل البيت الذين صرّح القرآن الكريم بطهارتهم؟ ومَن كان أجدر منه لأن يكون رجل (الاستمراريّة) وإعادة التقويم للإسلام الذي قيل فيه: بدؤه محمّدي وبقاؤه حسيني؟
ورجل نذر حياته للشهادة، وتقدّم بقوّة نحو افتداء عقيدته مضحّياً بنفسه وأهله، وشهيد أعطى معنىً كاملاً وتفسيراً واضحاً لمعاني تضحية الأنبياء والرسل بديناميكيّة ثورته وزخمها، وسيّد للشهداء أتمّ الشهادات العظيمة لكلّ الأديان، وناقض لكلّ نواميس الظلم والتحريف، ومعط ما لله لله، وما ليزيد ليزيد، تماماً كما أعطى قبله رسول المحبّة وشهيد المسيحيّة (ما لقيصر لقيصر، وما لله لله).
مثل هذا الشهيد الذي يذكّر كلّ مسيحي برسوله، ومثل هذا المعلّم للثورة من أجل الحقّ لخليق بأن يحلّ محلّه في ضمير الإنسان المسيحي، والجدير بالمسيحيين اعتباره شهيداً يخصّهم كما يخصّ المسلمين. وكما يجب أن يخصّ غيرهم من أتباع كلّ الديانات، فشهادته كانت أقرب الشهادات إلى روح وجوهر العقيدة المسيحيّة، وثورته - بمضامينها ومراميها - كانت أقرب الثورات التصاقاً بما جاء المسيح (عليه السّلام) لأجله نبيّاً ومبشّراً للمظلومين. فكان في شهادته من أجل الحق شهيداً في المسيحيّة التي تعصّبت للحقّ القراح دون أيّ تعصّب لقوميّة أو قبليّة أو عنصريّة.
فجدير بقدسيّة رسالة الحسين (عليه السّلام) أن يقدّمها العالم الإسلامي كأنصع ما في تاريخ الإسلام إلى العالم المسيحي، وكأعظم شهادة لأعظم شهيد في سبيل القِيَم الإنسانيّة الصافية، الخالية من أي غرض أو إقليميّة ضيّقة، وكأبرز شاهد على صدق رسالة محمّد (صلّى الله عليه وآله)، وكلّ رسالات الأنبياء التي سبقتها.
وليس أدلّ على ما لسحر شهادة الحسين (عليه السّلام) من قوّة جذب للشعور الإنساني من حادثة رسول قيصر إلى يزيد حينما أخذ هذا ينكت ثغر الحسين الطاهر بالقضيب
على مرأىً منه، فما كان منه إلاّ أن قال له - مستعظماً فعلته -: إنّ عندنا في بعض الجزائر حافر حمار عيسى، ونحن نحجّ إليه في كلّ عام من الأقطار، ونهدي إليه النذور ونعظّمه كما تعظّمون كتبكم، فأشهد أنّكم على باطل(1) .
فأغضب يزيد هذا القول وأمر بقتله، فقام إلى الرأس الطاهر وقبّله وتشهّد الشهادتين، وعند قتله سمع أهل المجلس من الرأس الشريف صوتاً عالياً فصيحاً يردّد: «لا حول ولا قوّة إلاّ بالله»(2) .
وحادثة اُخرى دفعت براهب مسيحي لأن يبذل دراهم مقابل تقبيل رأس الشهيد، وكان ذلك عند نصب الرأس على رمح إلى جنب صومعته، وفي أثناء الليل سمع الراهب تسبيحاً وتهليلاً، ورأى نوراً ساطعاً من الرأس المطهّر وسمع قائلاً يقول: السّلام عليك يا أبا عبد الله. فتعجّب حيث لم يعرف الحال! وعند الصباح استخبر القوم فقالوا له: إنّه رأس الحسين بن علي بن أبي طالب واُمّه فاطمة بنت النبي محمّد (صلّى الله عليه وآله)، فقال لهم: تبّاً لكم أيّتها الجماعة، صدقت الأخبار في قولها: إذا قُتل تمطر السماء دماً.
وأراد منهم أن يقبّل الرأس، فلم يجيبوه إلاّ بعد أن دفع إليهم دراهم، ولمّا ارتحلوا عن المكان نظروا إلى الدراهم وإذا مكتوب عليها:( وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ) (3) .
____________________
(1) الصواعق المحرقة / 119.
(2) مقتل العوالم / 151، ومثير الأحزان لابن نما، وفي مقتل الخوارزمي 2 / 72 ذكر محاورة رسول قيصر وغفل عن ذكر كلام الرأس الشريف.
(3) تذكرة الخواص / 150.
فبداهة القول إنّ أيّ فكر إنساني يطّلع على السيرة العطرة لسيّد الشهداء لا بدّ وأن تتحرّك في وجدانه نوازع الحبّ لهذا الشهيد المثالي، كما تحرّكت شبيهة هذه النوازع في قلبَي كلّ من رسول قيصر والراهب. ففي أعماق كلّ إنسان لواقط خفيّة تلتقط أدنى إشارات العظمة والقداسة خفوتاً، فكيف بأقواها تلك المتعلّقة بشخص سيّد الشهداء، والمنبعثة رغم السنين والقرون من كلّ كلمة في سفر حياته وكفاحه ومقتله، والتي تستهوي أشدّ القلوب ظلامة للتفاعل معها، وتوقظ أشدّ الضمائر مواتاً لاستلهامها والسير على هدي أنوارها السنيّة؟
ثورة الوحي الإلهي
دأب بعض المغرضين من مستشرقين وعرب على الوقوع في خطأ جسيم في كلّ مرّة يتصدّون فيها للكتابة عن ملحمة كربلاء، فيخلص بعضهم إلى القول: إنّ ثورة الحسين كانت عاطفيّة مرتجلة؛ قام بها الشهيد بغية إحراج الذين خذلوه خاصّة(1) ، وبني اُميّة والمسلمين عامّة(2) ، ويردّ البعض الآخر حركة الحسين إلى رغبته في إثارة المؤيّدين والرافضين على السواء، وتحميل ضمائرهم وزر قتل آل النبي(3) ، وحلّلها
____________________
(1) ورد في صحيح مسلم: أنّ طائفة من الجهلة قد تأوّلوا على الحسين وقتلوه ولم يكن له قتله، بل إجابته. فليس الأمر كما ذهبوا إليه، بل أكثر الأئمّة قديماً وحديثاً كاره ما وقع من قتله وقتل أصحابه سوى شرذمة قليلة من أهل الكوفة.
وذكر الحافظ ابن كثير في استشهاد الحسين / 107: أنّ ابن زياد لمّا صعد المنبر قال: إنّ الله فتح عليه من قتل الحسين الذي أراد أن يسلبهم الملك ويفرّق الكلمة عليهم.
(2) في كتابه (السياسة الإسلاميّة) يقول الفيلسوف الألماني ماربين: إنّ الحسين مع ما كانت له من المحبوبيّة في قلوب المسلمين كان بإمكانه تجهيز جيش جرّار لمقاتلة يزيد، لكنه قصد من استشهاده (الانفراد والمظلوميّة) لإفشاء ظلم بني اُميّة، وإظهار عداوتهم لآل النبي.
(3) الذين يؤيّدون هذا الرأي يستندون إلى كلام العقيلة زينب (عليها السّلام) في مجلس يزيد حينما قالت له: فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، ولا يرحض عنك عارها.
آخرون بأنّها ثورة أخلاقيّة كان الحسين يبتغي من ورائها عزل العقيدة المحمّديّة عن مسالك تهلكتها والنجاة بها إلى طريقها الصحيح(1) ، وحصَرها آخرون في إطار رغبة الاستيلاء على الحكم، والإيثار بالخلافة(2) . والذين لم يحلّلوها حسب رؤاهم اكتفوا بوصفها بالعاطفيّة وعدم التخطيط وحساب ما للحرب من نتائج وأساليب وما يترتّب عليها من نتائج.
ولو توفّر لكلّ هؤلاء المغرضين والمستبدّين بآرائهم البصيرة النافذة والرؤية المتبصّرة التي تردّ مؤشّرات الأحداث إلى منابعها، وتربط النهايات بالبدايات، والمسار بنقطة الانطلاق، والنتائج بالمسبّبات، لَما وقعوا فيما وقعوا فيه من مغالطات وتَجَنٍّ على الحقيقة، تجلّت في رؤية الأحداث والحقائق من وجهة نظر تفصيليّة ماديّة ضيّقة، وربط النتائج بالأسباب بكيفيّة تقليديّة على نحو ما اصطلح عليه العقل البشري في بعض اجتهاداته المحرّفة سيّئة المقاصد.
ولكن أنّى لهم ذلك إذا كانت السّوءة في هضم الحقائق فكرياً هي هدفهم الأسمى الذي يسعون إليه، ويُغذّون على نبراسه في دروب رؤاهم الموءودة بسكين وترتهم وضيق أفقهم وسوء نيّاتهم؟
فالقائلون: بأنّها ثورة مرتجلة، في قولهم كمَن يجدِّفون على الحكمة الإلهيّة التي هيّأت
____________________
(1) الشيخ عبد الله العلايلي في كتابه (الإمام الحسين) / 348 رأي يقول فيه: خروج الحسين (عليه السّلام) ليس فتنة - كما اتّهموا - بل لمكافحة الفتنة، فأيّة محاولة وثورة على الفساد في سبيل أن يكون الدين كلّه لله نحن مأمورون بها. فالحسين بخروجه لم يجاوز برهان ربّه:( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ) .
(2) للعقّاد في كتابه (أبو الشهداء) رأي يقول فيه: الحسين (عليه السّلام) طلب الخلافة بشروطها التي يرضاها، ولم يطلبها غنيمة يحرص عليها مهما تكلّفه من ثمن، ومهما تتطلّب من نتيجة، وفي هذا القول شبه بما قاله ماربين من أنّ خروج الحسين كان عزمة قلب كبير يبلغ به النصر الآجل بعد موته، ويحيي به قضيّة مخذولة ليس لها بغير ذلك حياة. العقّاد / 118.
الشهادة للحسين، ويستهينون بنبوءات الرسل والأنبياء عن قتله في فلاة كربلاء ذبيحاً وعطشان ومداساً بحوافر الخيل، ويسفّهون ما جاء على لسان الوصيّين والأبرار الذين ما جاؤوا إلى البشريّة إلاّ من أجل توطيد عقائدها وحفظ شرائعها.
فها هو شهيد المسيحيّة عيسى (عليه السّلام) يمرّ بأرض كربلاء، فينبئ عن قتل الحسين ويلعن قاتليه، ويصف أرض الطّف بـ(البقعة كثيرة الخير)(1) .
وقد أمسك بعض المشكّكين بهذه الواقعة لدعم تغرّضهم؛ فذكروا أنّ عيسى (عليه السّلام) لم يخرج من فلسطين طيلة حياته، وأنّه من غير المعقول أن يكون قد وصل إلى كربلاء في العراق، لكن هؤلاء فاتهم تلك الفترة الغامضة منذ يفاعة عيسى حتّى سنِّه العشرين، إذ لم تذكر التواريخ ولا حتى الإنجيل المقدّس أين أمضى عيسى طفولته وبعضاً من سنيّ شبابه المبكر؛ إذ هناك روايات تتحدّث عن سفره إلى التبت لنهل الحكمة والطبّ الروحي، وثمّة رواية أخرى تحدّثت عن تنقّله في كلّ بقاع الأرض لاختيار المواطن المناسبة لبعث ديانته ونشرها بعد نزولها عليه في فلسطين.
ونبيٌّ كعيسى أيّده الله بمعجزات خارقة هل يستحيل عليه الوصول إلى كربلاء بطرفة عين؟! وما هو غير المعقول في زيارة شهيد المسيحيّة إلى مسقط رأس شهادة الحسين (عليه السّلام) الذي سيأتي بعد قرون ليتمّم شهادة الحقّ والعدل التي استشهد لأجلها عليه السّلام؟
فإذا كانت الطبائع البشرية قد جبلت على تقديس الشهداء وحبّهم بوحيٍ من فطرتها الإنسانيّة، فكيف بالشهداء الذين تسبق شهادتهم شهادة نظائرهم ممَّن سيأتون لإتمام ما بدؤوه؟
____________________
(1) إكمال الدين - الصدوق / 295.
ألم يبكِ القتيل الحسين قبل مقتله بمئات السنين آدم والخليل وموسى، ويلعن عيسى قاتله ويأمر بني إسرائيل بلعنه، ويقول: مَن أدرك أيّامه فليقاتل معه؛ فإنّه كالشهيد مع الأنبياء مقبلاً غير مدبر؟(1)
فالحواجز الزمنية التي تحول بين البشر وبين استشفاف المستقبل ليس لها حساب مع الشهداء والنبيّين، فعليهم السّلام يرون قائمة الشهادة التي نصبها سبحانه وتعالى، ويقرؤون بها أسماء مَن سيلي بعدهم مع صحيفة تبيّن كيفيّة المقتل واُسلوب المعاناة، وإلاّ لِمَ بكَ الحسين كلّ هؤلاء الأنبياء، ولعنوا قاتليه قبل أن تكون الواقعة بمئات السنين؟!
والله سبحانه وتعالى أعطى الأنبياء والأخيار مَلَكة نورانيّة تساعدهم على استجلاء الغيب:( عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً * إِلاَّ مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ )(2) ، وكان أبو جعفر (عليه السّلام) يقول: «كان والله محمد ممّن ارتضاه، ولم يبعد الله الخلفاء عن هذه المنزلة بعد اشتقاقهم من النور المحمّدي»(3) .
فلا توافق بين الارتجال الذي نعت البعض به ثورة الحسين، وبين نبوءات الأطهار ممّن ارتضاهم الله، ولا يصيبنّ ناعت في نعت استشهاد أبي الشهداء مهما بلغت فصاحته؛ لأنّه مستمدّ من القدر الإلهي، وموحى به قبل أن يولد الشهيد.
وكأنّي أسمع أحدهم يقول - مشكّكاً -: ولكن الحسين كان بإمكانه تجنّب التهلكة التي ألقى بنفسه وآل بيته إليها، عملاً بقول الآية الكريمة:( وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) . إلاّ أنّ منطق الشهادة يبرّر معنى الآية إذا كان في الحفاظ على
____________________
(1) كامل الزيارات / 67 ابن قولويه.
(2) سورة الجن / 26 و 27.
(3) البحار 15 / 74، وابن حجر في فتح الباري 13 / 284 كتاب التوحيد.
النفس مصلحة أهم من إزهاقها، والاقتصار على ما يقتضيه الوصف يخرج الآية عمّا في الشهادة من نفي للهلكة، فإنّها أعقبت آية الاعتداء في الأشهر الحرم على المسلمين، فقال تعالى:( الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ * وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) (1) .
والحسين (عليه السّلام) كان عالماً بمقتله، وواعياً لكلّ ما سيحيق به، وإقدامه على الشهادة إنّما كان من باب الطاعة وامتثالاً للتكليف الموجّه إليه من القدرة الإلهيّة.
وقد أعْلَمَ اُمّ سلمة بقتله قائلاً لها: «إنّي أعلم اليوم الذي اُقتل فيه، والساعة التي اُقتل فيها، وأعلم مَن يُقتل من أهل بيتي وأصحابي. أتظنّين أنّك علمت ما لم أعلمه؟ وهل من الموت بُدّ؟ فإن لم أذهب اليوم ذهبت غداً».
والارتجالية هي عكس معرفة كلّ شيء بالتفصيل كما قال الشهيد لاُمّ سلمة حين أبدت له خوفها من سفره، ومعرفته بما سيحلّ به لم يؤخّره أو يمنعه عن التقدّم والتسليم للقضاء المحتوم، وعدم التوسّل إلى الباري تعالى في إزاحة العلّة لينال الشهادة.
ولو شاء سيّد الشهداء أن يدفع الله تعالى عنه هذه التهلكة لكان ذلك على الله أسرع من سلك منظوم انقطع، ولرفع عنه الطواغيت، لكن الحكمة المتجلّية في عدم طلب مثل هذا الدفع لا يعلمها إلاّ ربّ العالمين.
والأنبياء الذين قتلوا في سبيل إعلاء كلمة الله المبشّرة بالحقّ والعدل أنظنّ نحن البشر بأنّ الله تعالى قد تخلّى عنهم لمصائرهم؟ كلاّ، بل إنّهم (عليهم السّلام) يتشوّقون للشهادة تقرّباً من قدس الله وتنفيذاً لمشيئته، ولو دَعَوا الله لِرفعها عنهم، لَرفعها.
لكنّهم يدورون مدار ما اختاره تعالى لهم من الأقضية والأقدار، إذا كان في إقدامهم إبقاءٌ على دين، أو حفظاً لشريعة، أو إنقاذاً لعقيدة.
____________________
(1) سورة البقرة / 194 و 195.
وقد تنبّأ عيسى (عليه السّلام) بموته أمام تلاميذه، وشرح لهم كلّ ما سيحدث له من تسليمه إلى الوثنيين وسخريتهم منه وجَلْدِه وقتله، وحثّ تلميذه الخائن يهوذا الاسخريوطي على تسليمه، ولمّا اجتذبه تلميذه بطرس إليه وطفق يحذّره من المضيّ إلى القدس، التفت (عليه السّلام) إلى تلميذه وقال له: «اذهب خلفي يا شيطان، إنّك لي معثرة؛ لأنّ أفكارك ليست أفكار الله، بل أفكار الناس».
ولمّا هوى أحد أصحابه بسيفه على أذن عبد عظيم الأحبار وقطعها، قال له المسيح: «اغمد سيفك، فمَن يأخذ بالسيف يهلك، أو تظنّ أنّي لا أستطيع أن أسأل ربّي فيمدّني الساعة بأكثر من اثني عشر فيلقاً من الملائكة؟! ولكن كيف تتمّ آيات الكتب التي تقول: إنّ هذا ما يجب أن يحدث؟»(1) .
فعيسى بن مريم كان قادراً إذا طلب من ربّه أن يقضي على اليهود الذين جاؤوا لاعتقاله، لكنّه لم يفعل حتّى تتمّ مشيئة الواحد القهّار التي لا يفهمها النّاس العاديّون كتلميذه بطرس.
وعندما كان تلاميذه يسهرون ليلة قال لهم: «نفسي حزينة حتّى الموت». ثمّ أبعد قليلاً وأكبّ لوجهه يصلّي ويقول: «يا ربّاه، لتبتعد عنّي هذه الكأس إن كان يُستطاع، ولكن لا كما أنا أشاء، بل كما أنت تشاء»(2) .
ولم يلح نبيّ المسيحيّة على طلب إبعاد كأس الموت عنه كما يشاء هو، بل كما يشاء ربّه الأعلى. وكما قال عيسى (عليه السّلام): «لا كما أنا أشاء بل كما أنت تشاء»، قال سيّد الشهداء مخاطباً أخاه محمّد بن الحنفيّة: «شاء الله أن يراني قتيلاً، ويرى النساء سبايا».
____________________
(1) متّي 26 / 53 - 54 - 55.
(2) مرقس 14 / 36 - 37.
فهل للمشكّكين بوعي ثورة الحسين من حجّة بعد هذا القول «شاء الله أن يراني قتيلاً» من وصف ثورته بالعاطفيّة وسوء التخطيط؟ وما قولهم بمشيئة الله القادر الذي خطّط لثورة سيّد الشهداء وأجراها نبوءات على ألسنة رسله الأطهار، وأنزلها وحياً على ذبيحها الذي سيكون قربانها الرئيسي؟ هل سيبلغ بهم الكفر حدّاً لنعتها بأيّ نعتٍ آخر إزاء مقولة الحسين بمشيئة ربّه؟
هذه المشيئة المقدّسة هي التي جعلت إبراهيم الخليل (عليه السّلام) يحطّم آلهة قومه ويدوسها بقدميه غير عابئ بالنمرود صاحب البطش، وبالنّار التي أوقدها لحرقه حيّاً.
وهي المشيئة الإلهيّة التي دفعت بكليم الله موسى (عليه السّلام) ليقف في وجه فرعون المتألّه، ملك النيل والسلطان العريض، ويصيح أمامه: «أنت ضالٌ مُضِل».
هي مشيئة الواحد القهّار التي دفعت بيحيى (عليه السّلام) للصراخ في وجه هيرودس عندما أراد التزوّج بامرأة أخيه قائلاً له: «إنّها لا تحلّ لك». ولمّا رقصت ابنة هيروديا إحدى بغايا بني إسرائيل، قدّم لها هيرودس رأس يحيى (عليه السّلام) على طَبَق من ذهب.
هي المشيئة التي رسمت لعيسى (عليه السّلام) مواقفه وحياته، فقال لأحبار اليهود (أنتم أبناء الشياطين). رغم علمه بأنّه سيُقتل.
وهي المشيئة العليا التي أوحت للنبيّ محمّد (صلّى الله عليه وآله) اليتيم الفقير، لتسفيه أحلام قريش، وسبّ آلهتهم، وحمل الرسالة المحمّديّة والاندفاع بها مهدّداً كسرى وقيصر شرقاً وغرباً.
وقال أمير المؤمنين: «أوحى الله إلى داود: تريد واُريد ولا يكون إلاّ ما اُريد؛ فإن سلّمت لِما اُريد اُعطيتَ ما تريد، وإن لم تسلّم لِما اُريد أتعبتك فيما تريد، ثمّ لا
يكون إلاّ ما اُريد». وقال: «لا تسخط الله برضا أحد من خلقه؛ فإنّ في الله خَلَفاً من غيره، وليس من الله خلف في غيره». وقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): «مَن طلب رضى مخلوق بسخط الخالق سلّط الله عليه ذلك المخلوق».
بهذه المبادئ العلويّة جاء الأنبياء والرسل والشهداء إلى البشريّة مبشّرين بالأديان السماويّة، مقاتلين دون تحريفها، باذلين الأنفس والمهج في سبيل ترسيخها في النفوس، وعندما يقف هؤلاء الأطهار أمام أصحاب السّطوة والاستطاعة فإنّهم يقفون بقوّة العزّة الإلهيّة التي لا قوّة فوقها، ويخاطبون أهل السلطان باسم الله الذي أوحى لهم ما يقولون، ورسم لهم أدوارهم التي بعثهم للبشريّة من أجلها.
وأيّة اجتهادات في تفسير هذه الأدوار بغير هذا المنطق معناه وضع الحقائق الجوهريّة في غير موضعها، حتّى لتبدو الرغبة في التضليل واضحة فيمَن يقدمون على مثل هذا التحريف في أخذ منطق هذه الحقائق.
وثورة الحسين (عليه السّلام) ليست وليدة ساعتها، بل هي في سفر الوصايا الإلهيّة نقشت عليه قبل نزول الرسالة المحمّديّة، وعِلم ذلك عند ربّ الأكوان وباعث الرّسالات، إذ كان يعلم تعالى بما ستتعرّض له هذه الرسالة من اهتزاز بعد نزولها على محمّد (صلّى الله عليه وآله) فهيّأ لها الحسين قبل أن يكون.
فها هو الشهيد يقول لعبد الله بن جعفر: «إنّي رأيت رسول الله في المنام، وأمرني بأمرٍ أنا ماضٍ له». وفي بطن العقبة قال لمَن معه: «ما أراني إلاّ مقتولاً، فإنّي رأيت في المنام كلاباً
تنهشني، وأشدّها عليّ كلب أبقع»(1) .
ولمّا أشار عليه عمرو بن لوذان بالانصراف عن الكوفة إلى أن ينظر ما يكون عليه حال النّاس، قال (عليه السّلام): «ليس يخفى عليَّ الرأي، ولكن لا يغلب على أمر الله. وإنّهم لا يدعوني حتّى يستخرجوا هذه العقلة من جوفي»(2) .
وفي مكّة حينما أراد السفر منها إلى العراق قال: «كأنّي بأوصالي هذه تقطّعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن منّي أكراشاً جوفاً، وأجربة سغباً. لا محيص عن يومٍ خُطّ بالقلم»(3) .
فعبارة (لا محيص عن يومٍ خُطّ بالقلم)، دلالة واضحة على أنّ سيّد الشهداء كان عالماً بأنّ مصيره قد خُطّ بالقلم، وأن لا مندوحة من الامتثال لمشيئة الله القادر دونما تساؤل عن هذا السرّ الإلهيّ، فالأنبياء والشهداء والمصطفون لا يسألون: (لماذا، وكيف؟) بل هم يمضون في دربهم على هَدي الإيحاءات العلويّة التي تنير لهم دربهم خطوة إثر خطوة.
وهذا السرّ العلوي هو الذي منع الإمام المجتبى الحسن ابن أمير المؤمنين (عليه السّلام)، من السؤال حينما حلّ الأجل تسليماً لقضاء القوّة الإلهيّة، ودفعه لأن يمدّ يده بلا ارتعاش إلى جعدة بنت الأشعث ليتناول منها اللبن المسموم ويرفع رأسه إلى السماء قائلاً: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون، الحمد لله على لقاء محمّد سيّد المرسلين، وأبي سيّد الوصيّين، واُمّي سيّدة نساء العالمين، وعمّي جعفر الطيّار في الجنّة، وحمزة سيّد
____________________
(1) كامل الزيارات / 75.
(2) تاريخ الطبري 6 / 226، وإرشاد المفيد، ونفس المهموم للمحدّث القمّي / 98.
(3) اللهوف / 33، وابن نما / 20.
الشهداء»، ثمّ يشرب اللبن المسموم وهو يدعو على جعدة بالخزي(1) .
وهذا السرّ العلوي هو الذي أوحى للرضا (عليه السّلام) بأنّ منيّته تكون على يد المأمون ولا بدّ من الصبر حتّى يبلغ الكتاب أجله. وقال أبو جعفر الجواد لإسماعيل بن مهران لمّا رآه قلقاً من إشخاص المأمون له: «إنّه لم يكن صاحبي، وسأعود من هذه السفرة». ولمّا أشخصه المرّة الثانية قال (عليه السّلام) لإسماعيل: «في هذه الدفعة يجري القضاء المحتوم»(2) ، وأمره بالرجوع إلى ابنه الهادي فإنّه إمام الاُمّة بعده، ولمّا حلّ قضاء الله ودفعت إليه اُمّ الفضل المنديل المسموم لم يمتنع عن استعماله تسليماً لطاعة المولى.
وفي هذا الرضوخ للقوّة العلوية تفسير في الآية الكريمة:( وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظاً ) (3) .
وهذا ما يفسّر أيضاً المعاناة التي ذاقها الأنبياء، خاصّة النبي محمّد (صلّى الله عليه وآله) وآل بيته الأطهار وقد قال: «ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت». وأوصاه الله بالصبر حيث قالت عزّته:( فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنْ الرُّسُلِ ) .
لكن ما صبر عليه الحسين (عليه السّلام) وصحبه كان أشدّ من كلّ المعاناة التي وقعت بالأنبياء والرسل، كانت أشدّ هولاً وفتكاً وآلاماً، وقد صبر الشهيد وطالَب أهله وصحبه بالصبر ابتغاء لمرضاة الله: «صبراً بني الكرام، فما الموت إلاّ قنطرة تعبر بكم عن البؤس والضرّاء إلى الجنان الواسعة، والنّعيم الدائم، فأيّكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر؟ وما هو
____________________
(1) البحار 10 / 133 عن عيون المعجزات، والإرشاد للمفيد، والخرائج.
(2) الإرشاد وإعلام الورى / 205.
(3) سورة الأحزاب / 7.
لأعدائكم إلاّ كمَن ينتقل من قصر إلى سجن وعذاب. إنّ أبي حدّثني عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أنّ الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر، والموت جسر هؤلاء إلى جنّاتهم، وجسر هؤلاء إلى جهنّم، ما كذّبتُ ولا كُذِّبت».
وهو يودّع عياله قال لهم: «استعدّوا للبلاء، واعلموا أنّ الله حاميكم وحافظكم، وسينجيكم من شرّ الأعداء، ويجعل عاقبة أمركم إلى خير، ويعذّب عدوّكم بأنواع العذاب، ويعوّضكم عن هذه البليّة بأنواع النعم والكرامة، فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم»(1) .
وهذا الصبر النادر العجيب الذي تحلّى به الأنبياء والشهداء، فمنعهم حتّى من التساؤل عن سبب ما يبتلون به. هو الذي يعجز تفكيرنا البشري عن إدراك ماهيّته، إلاّ أنّنا من وجهة قدرتنا المحدودة لا نملك إلاّ أنّ نفهم الحكمة الإلهيّة التي سنّت لهؤلاء الأخيار سُنن الشهادة، فكأنّهم فرحون بها، وفرحهم يمنعهم حتّى من التساؤل ما داموا قد أعطوا ملكة تبصّر نتائج صبرهم واستشهادهم، وما هيّأه الله سبحانه وتعالى لهم من نِعَمٍ وجنان.
ويحثّ عيسى (عليه السّلام) تلاميذه الذين سيحملون رسالة المسيحيّة من بعده، يحثّهم أيضاً على الصبر، قائلاً عندما دنت ساعته: «الآن تؤمنون! ها هي الساعة آتية، وإنّها قد أتت، تتفرّقون فيها فيذهب كلّ واحد في سبيله، وتتركوني وحدي! كلاّ لست وحدي، إنّ الربّ معي، قلت لكم هذه الأشياء ليكون لكم بي السّلام، ستعانون الشدّة في العالم، فاصبروا لها لقد
____________________
(1) جلاء العيون للمجلسي / عن المقتل للمقرم.
غلبتُ العالم»(1) .
والرؤيا التي استشفّها الحسين (عليه السّلام) في خضمّ الشدائد التي حلّت به وبآل بيته وصحبه، فبشّرهم بتعويض بليّتهم بنعمٍ وكرامة. هي ذات الرؤيا التي بشّر بها المسيح رسله بقوله: «ستبكون وتنتحبون، ستحزنون ولكن حزنكم سيتبدّل فرحاً»(2) .
فما الذي يمكن لنا كباحثين ومطّلعين أن ندركه من هذه الأمثولات الإلهيّة التي لا مجال لنا إلى إدراكها أو الغوص في حكمتها المقدّسة؟ وما الرأي لدى اُولئك المشكّكين بواقعيّة ووعي ثورة الحسين بكلّ ما سبق ذكره، من أنّ البررة كتبت لهم حياتهم ومصائرهم في (الصحيفة الإلهيّة) التي يقف عليها الأنبياء فتتكشّف أمامهم حجب الغيب وتهتك لوعيهم ستر المستقبل؟
ألا يصحّ بموقف الذين تناولوا ثورة الحسين (عليه السّلام) بمقياس الربح والخسارة والثورات العسكريّة والنتائج الماديّة والزمانيّة والمكانيّة في حينها، ألا يصحّ فيهم وبسوءة نواياهم، قول الإمام أبي جعفر الباقر (عليه السّلام): «إنّي لأعجب من قوم يتولَّونا ويجعلونا أئمّة، ويصفون أنّ طاعتنا مفترضة كطاعة رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، ثمّ يكسرون حجّتهم ويخصّون أنفسهم لضعف قلوبهم؛ فينتقصونا حقّنا، ويعيبون ذلك على مَن أعطاه الله برهان حقّ معرفتنا والتسليم لأمرنا! أترون الله تعالى افترض طاعة أوليائه على عباده ثمّ يخفي عليهم أخبار السماء، ويقطع عنهم مواد العلم فيما يرد عليهم مما فيه قوام دينهم؟!»(3) .
____________________
(1) يوحنا 16 / 32 - 33.
(2) يوحنا 16 / 20.
(3) الكافي على هامش مرآة العقول 1 / 190 باب أنّهم يعلمون ما كان، وبصائر الدرجات - الصفّار / 33، والخرائج للراوندي / 143 طبعة الهند.
الحسينُ يستوحي مقتله
قبل خروجه من مكّة وقف يخطب بما اُوحيَ له في قصّة استشهاده، حتّى كأنّه يقرأ مخطوطاً أمام ناظريه. قال (عليه السّلام): «الحمد لله، وما شاء الله، ولا قوّة إلاّ بالله، وصلّى الله على رسوله. خُطّ الموت على وُلد آدم مخطّ القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. وخُيّر لي مصرع أنا لاقيه، كأنّي بأوصالي تقطّعها عسلان الفلاة بين النواويس وكربلاء، فيملأن منّي أكراشاً جوفاً، وأجربة سغباً، لا محيص عن يوم خُطّ بالقلم، رضى الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفّينا اُجور الصابرين.
لن تشذّ عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حضيرة القدس؛ تقرّ بهم عينه وينجز بهم وعده. ألا ومَن كان فينا باذلاً مهجته، موطّناً على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإنّي راحل مصبحاً إن شاء الله تعالى»(1) .
وحاول جماعة من أهل بيته وصحبه صرفه عن السفر والتريّث خوفاً من غدر أهل الكوفة، لكنّه (عليه السّلام) كان يصارح الجميع بما كتب له، وبما يوحى إليه، وكان شوقه للقاء أسلافه ينعكس نوراً سنيّاً فوق صفحة وجهه، فكان يخيّل للناظر إلى شيبته المقدّسة بأنّه لم يعد متواجداً على هذه الأرض إلاّ بجسده فقط، وأنّ تلهّفه للشهادة طار بوجدانه وفكره إلى حيث يريه الله تعالى مكانه في النعيم بعد قليل من الوقت؛ لذا فقد أجاب ابن الزبير: «إنّ أبي حدّثني أنّ بمكّة كبشاً به تُستحلّ حرمتها، فما أحبّ أن أكون ذلك
____________________
(1) اللهوف / 33، وابن نما / 20.
الكبش، ولئن اُقتل خارجاً منها بشبر أحبّ إليّ من أن اُقتل فيها. وايم الله لو كنت في ثقب هامة من هذه الهوام لاستخرجوني حتّى يقضوا فيّ حاجتهم. والله ليعتدنّ عليّ كما اعتدت اليهود في السبت»(1) . وكان الوحي ينزل فوق رأسه فينقله إلى مطارح مصرعه، ولم يشأ (عليه السّلام) أن يتحدّث برؤاه لأحد حتّى يلقى ربّه ذا الجلال.
ولمّا أقام (عليه السّلام) في (الخزيمية) يوماً وليلة أقبلت إليه اُخته زينب (عليها السّلام) وقالت: إنّي سمعت هاتفاً يقول:
ألا يا عينُ فاحتفلي بجُهدي |
فمَن يبكي على الشهداءِ بعدي |
|
على قومٍ تسوقهُمُ المنايا |
بمقدارٍ إلى إنجازوعدي |
فقال: «يا اُختاه، كلّ الذي قضي فهو كائن»(2) .
ومع عبارة (كلّ الذي قضي فهو كائن) يختتم الحسين (عليه السّلام) سلسلة رؤاه في كلّ ما سيبلوه الله به فوق أرض كربلاء، وبهذه العبارة ردُّ كافٍ على أهل المظنّة الذين نعتوا ثورته بـ (الغضبة العسكريّة) التي كان ينقصها التخطيط العسكري السّليم كي تبلغ النصر في ميزان النصر، وكأنّ السرّ الإلهي أعمى على قلوب هؤلاء فحجب عن بصائرهم فهم مغزى الثورة على حقيقتها. وبأنّ قوّتها تكمن في ضعفها العسكري، وبأنّ نصرها منبثق من انكسارها، وبأنّ فلاحها مستمدّ من خذلانها، وبأنّ عظمتها
____________________
(1) تاريخ مكّة للأزرقي 2 / 150.
(2) وردت في مجلّد ابن نما / 23.
التي ما زادتها القرون إلاّ تأجّجاً، كانت من لُحمة العظمة الربّانيّة التي رسمتها بهذا الشكل الذي قضيت به، كي تكون نتائجها وآثارها بالشكل الذي آلت إليه.
فيا ليت اُولئك المتجرّئين على ردّ حقائق ثورة فرخ النّبي وريحانته، وسيّد شباب أهل الجنّة وأبي الشهداء في عمر البشريّة إلى غير منابعها ومصبّها! يا ليتهم يرعوون ويثوبون عن غيّهم وكفرهم قبل أن تنزل بهم العناية الإلهيّة غضبتها؛ نتيجة ما أوّلوا حكمتها - التي لا يرقى إليها عقل بشري - إلى تأويلات شتّى سداها الضعف البشري، ولُحمتها الكفر بالمسلّمات والبدهيّات العُلوية!
معجزاتُ الشهادة
المعجزات التي تعقب الشهادات العظيمة، ما هي إلاّ غضبة الخالق من عقوق خلقه الذي انتهى إلى قتل شهيده، وسبحانه يجري هذه المعجزات بشكل صاعق له ردّة الصدمة الكهربائية العنيفة؛ بهدف إيقاظ الضمائر لتنظر فيما جرى، بقتلها هذا الشهيد الذي لم يؤتَ على حياته بأيّة معجزات تنجيه من مصيره المحتوم، فكانت المعجزات بعد مماته شاهداً على قدرة الله، وتوكيداً على مكانة الشهيد المقدّس، وبأنّ ما قاله وبشّر به هو صوت الحقّ الإلهي الذي يتوجّب على الجميع إعادة سماعه إذا فاتهم ذلك والشهيد بينهم حيٌ بطبيعة بشريّة لم تكن كافية لمَن قست قلوبهم وغلظت ضمائرهم، كي تقنعهم بقوّة العدل الذي جاء يبشّر به.
وقد اشترك الأنبياء والشهداء بقواسم مشتركة عديدة، أفاضت على عقول الناس فيضاً من تشابه الرسالات السماويّة في جوهرها الأصلي، وإن اختلفت باختلاف أساليبها التي لو شاء المولى (عزّ وجلّ) لجعلها واحدة، لكنّ قوة إقناعها تكمن في اختلافها. وما دامت حياة الأبرار المختارين من الله تتشابه في ابتلائهم بشتّى الرزايا، وبصبرهم الواحد حيالها، وبنهاياتهم الأليمة التي لولاها لَما كان ثمّة أديان
حفظت لنا حتّى الآن. فإنّ الصدمات الإلهيّة التي تعقب استشهادهم هي من التشابه والقوّة بحيث لا تدع مجالاً للشكّ بأنّها الانطباعات الفوريّة والقويّة على مكانة الشهيد وعظم رسالته.
وإذا كنّا في صدد الحديث عن أوجه الشبه بين شهيدي المسيحيّة والإسلام عيسى والحسين (عليهما السّلام) فإنّا لواجدون هذا الشبه جليّاً في نوعيّة المعجزات التي أعقبت شهادتَيهما، بما تتلاءم مع قسوة ميتتيهما، وإذا كنّا راغبين في حصر هذا التشابه بين الشهيدين العظيمين، فذلك انسجاماً مع بحثنا لمدى فهم الفكر المسيحي خاصّة والإنساني عامّة لملحمة استشهاد الحسين، بإبراز كلّ نقاط التشابه التي تدنيها من ملحمة فداء عيسى.
حينما استشهد الحسين (عليه السّلام) اظلمّت الدنيا ثلاث أيّام واسودّت سواداً عظيماً حتّى ظنّ الناس أنّ القيامة قامت، وبدت الكواكب نصف النهار، ولَم يرَ نور الشمس ثلاثة أيّام كاملة، حيث كان سيّد شباب أهل الجنّة عارياً على وجه الصعيد(1) .
وحينما استشهد عيسى (عليه السّلام) انتشر ظلام شديد على الأرض كلّها منذ الساعة السادسة إلى التاسعة، حيث لفظ المسيح روحه وصرخ صرخة قويّة، وإذا ستار الهيكل قد انشقّ شطرَين من الأعلى إلى الأسفل، وزلزلت الأرض، وتصدّعت الصخور، وتفتّحت القبور(2) .
هاتان المعجزتان العظيمتان تدلاّن على عظمة الشهيدَين، وعلى عظم غضبة
____________________
(1) تاريخ ابن عساكر 4 / 339، والخصائص الكبرى 2 / 126، والصواعق المحرقة / 116، والخطط المقريزيّة 2 / 289، وتذكرة الخواص / 155، ومقتل الحسين (عليه السّلام) للخوارزمي 2 / 90، وابن لهيعة عن أبي قبيل المعافري إذ قال: إنّ الشمس كسفت حتّى بدت النّجوم وقت الظهر، وإنّ الأرض أظلمت.
(2) متّي 27 / 51 - 52.
الخالق سبحانه وتعالى، الذي أظلم الدنيا ثلاث أيّام طيلة بقاء سيّد الشهداء عارياً في فلاة كربلاء، وأظلمها ثلاث ساعات طيلة بقاء شهيد المحبّة عارياً في الجلجلة؛ كي لا تكشف عريهما المقدّس عين، ومن أجل إشراك الظواهر الطبيعيّة التي هي إحدى العلل في مجرى الكَون(1) ، والذي أوقف هذا المجرى شهادتا عيسى والحسين غضباً على مقتلهما، وإظهاراً لغضبة الخالق على خلقه الذين اضطهدوا وقتلوا الشهيدَين العظيمَين.
وعن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السّلام): «إنّ السماء بكت على الحسين أربعين صباحاً بالاحمرار، والأرض بكت أربعين صباحاً بالسواد، والشمس بكت عليه أربعين صباحاً بالكسوف والحمرة»(2) .
وبعد ثلاث أيّام من دفن عيسى حدث زلزال شديد وهبط ملاك الربّ نازلاً من السماء ودحرج حجر القبر الضخم وقعد عليه، وكان هذا إيذاناً بقيامة المسيح من بين الأموات صاعداً إلى السماء كما جاء في الآية التي نزلت يوم مولده(3) .
وفي ذات الليلة رأت اُمّ سلمة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في المنام أشعث مغبّراً وعلى رأسه التراب، فقالت له: يا رسول الله، ما لي أراك أشعث مغبّراً؟! قال: «قُتل ولدي الحسين، ومازلت أحفر القبور له ولأصحابه»(4) . فانتبهت فزعة ونظرت إلى
____________________
(1) استنكر بعض المؤرّخين حدوث مثل هذه الظواهر، ووصفها ابن تيمية في كتابه (رأس الحسين) ط القاهرة / 130، بالغلوّ في الإيراد، وفي المسيحية تقدير لهذه الظواهر كجزء من علل الكون المسيّر بعناية إلهية، فقد ورد في أعمال الرسل 2 / 19 - 20 قول عزّته: (وأجعل علوّاً أعاجيب في السماء، وسفلاً آيات في الأرض، فتتبدّل الشمس بنورها ظلاماً، والقمر دماً).
(2) وردت في عدّة مصادر سأذكرها بدون ترقيم وهي: الخصائص الكبرى، تاريخ ابن عساكر، تذكرة الخواص، الإتحاف بحب الأشراف، المناقب لابن شهر آشوب، النجوم الزاهرة، كنز العمال، الصواعق المحرقة.
(3) متّي 27 / 2 - 3.
(4) راجع أمالي الشيخ الطوسي / 56، وتهذيب التهذيب 2 / 356، وذخائر العقبى - المحب الطبري / 148، وتاريخ الخلفاء - السيوطي / 139، وسير أعلام النبلاء - الذهبي 3 / 213.
القارورة التي فيها تراب أرض كربلاء فإذا به يفور دماً، وهو التراب الذي دفعه النبي (صلّى الله عليه وآله) إليها وأمرها أن تحتفظ به(1) ، وقد سمعت ليلتها صوتاً هاتفاً في جوف الليل ينعى الحسين (عليه السّلام) فيقول:
أيها القاتلونَ جهلاً حسيناً |
أبشروا بالعذابِ والتنكيلِ |
|
قد لُعنتمْ على لسان ابنِ داو |
دَ وموسى وصاحبِ الإنجيلِ |
|
كلّ أهل السماء يدعو عليكُمْ |
من نبيّ ومرسلٍ وقبيل(2) |
وفي يوم عاشوراء رأى ابن عبّاس رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أشعث مغبّراً، وبيده قارورة فيها دم، فقال له: بأبي أنت واُمّي ما هذا؟! قال: «هذا دم الحسين وأصحابه، لم أزل التقطه منذ اليوم»(3) .
ويحدّث دعبل الخزاعي عن جدّه: أنّ اُمّه سعدى بنت مالك الخزاعيّة أدركت الشجرة التي كانت عند اُمّ معبد الخزاعيّة وهي يابسة، وببركات وضوء النبي (صلّى الله عليه وآله) في أسفلها أورقت وأثمرت كثيراً. ولمّا قبض النبي (صلّى الله عليه وآله) قلّ ثمرها، ولمّا قُتل أمير المؤمنين (عليه السّلام) تساقط ثمرها، وكانوا يتداوون بورقها.
____________________
(1) راجع مرآة الجنان لليافعي 1 / 134، وكامل ابن الأثير الجزء 38، ومقتل الخوارزمي 2 / 95.
(2) راجع تاريخ ابن عساكر 4 / 341 فقد ذكرت الأبيات الثلاثة، وفي تاج العروس 7 / 103 ذكر البيت الأوّل والثالث - نقلاً عن المقرم.
(3) تفرّد به الإمام أحمد / 242 وإسناده قوي، وذكر في تاريخ بغداد للخطيب 1 / 142، وفي طرح التثريب / 22.
وبعد برهة نظروا إليها وإذا بساقها ينبع دماً، فأفزعهم هذا الحادث، ولمّا أظلم الليل سمعوا بكاءً وعويلاً ولم يروا أحداً، وقائل يقول:
يابنَ الشهيدِ ويا شهيداً عمُّهُ |
خيرُ العمومةِ جعفرُ الطيّارُ |
|
عجباً لمصقولٍ أصابحدّهُ |
في الوجهِ منك وقد علاك غبارُ |
وقد أخذ البيت الثاني أحد شعراء الشيعة القدامى ونظمه في ثلاث أبيات، يقول فيها:
عجباً لمصقولٍ علاك فرندهُ |
يومَ الهياجِ وقد علاك غبارُ |
|
ولأسهمٍ نفذتكَ دونَ حرائرٍ |
يدعون جدّكَ والدموعُ غزارُ |
|
هلاّ تكسّرتِ السّهامُ وعاقها |
عن جسمِكَ الإجلالُ والإكبارُ(1) |
وإذا كانت الطبيعة والوحوش والأشياء قد انفلتت من إسارها، وانفعلت حزناً على الحسين، فإنّ الرسول الكريم (صلّى الله عليه وآله) الذي قال: «حسين منّي وأنا من حسين». حضر المعركة التي عذّب فيها بضعته وريحانته، وشاهد ذلك الجمع الحاقد المتألّب على استئصال أهله من جديد الأرض وبمرأى منه عويل الأيامى ونشيج الفاقدات وصراخ الصبية من الظمأ، وقد سمع العسكر صوتاً
____________________
(1) مناقب ابن شهر آشوب 2 / 380.
هائلاً: ويلكم يا أهل الكوفة! إنّي أرى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ينظر إلى جمعكم مرّة وإلى السماء اُخرى وهو قابض على لحيته المقدّسة. لكن الهوى والضلال المستحكم في نفوس ذلك الجمع المغمور بالأطماع، أوحى إليهم (إنّه صوت مجنون)، فصاح الجمع: لا يهولنّكم ذلك. وكان أبو عبد الله الصادق (عليه السّلام) يقول: «لا أراه إلاّ جبرائيل»(1) .
ولمّا حمل الرأس الشريف إلى دمشق ونصب في موضع الصيارفة وهناك لغط المارة وضوضاء المتعاملين، فأراد سيّد الشهداء توجيه النفوس نحوه ليسمعوا عظاته، فتنحنح الرأس تنحنحاً عالياً، فاتجهت إليه الناس واعترتهم الدهشة حيث لم يسمعوا رأساً مقطوعاً يتنحنح قبل يوم الحسين (عليه السّلام)، فعندها قرأ سورة الكهف إلى قوله تعالى:( إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدىً ) (2) .
وصُلب على شجرة فاجتمع الناس حولها ينظرون إلى النور الساطع فأخذ يقرأ:( وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ) (3)(4) .
وقال هلال بن معاوية: رأيت رجلاً يحمل رأس الحسين (عليه السّلام) والرأس يخاطبه فرّقت بين رأسي وبدني، فرفع السوط وأخذ يضرب الرأس حتّى سكت(3) .
ويحدّث ابن وكيدة: إنّه سمع الرأس يقرأ سورة الكهف فشكّ في أنّه صوته أو غيره، فترك (عليه السّلام) القراءة والتفت إليه يخاطبه: «يابن وكيدة، أما علمت أنّا معشر الأئمّة أحياء عند ربّهم يرزقون؟».
____________________
(1) كامل الزيارات.
(2) سورة الكهف / 13.
(3) سورة الشعراء / 227.
(4) ابن شهر آشوب 2 / 188.
(5) شرح قصيدة أبي فراس / 148.
فعزم على أن يسرق الرأس ويدفنه، وإذا الخطاب من الرأس الشريف: «يابن وكيدة، ليس إلى ذلك من سبيل؛ إنّ سفكهم دمي أعظم عند الله من تسييري على الرمح، فذرهم فسوف يعلمونإِذِ الأَغْلاَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاَسِلُ يُسْحَبُونَ »(1) .
وقال المنهال بن عمرو: رأيت رأس الحسين بدمشق على رمح وأمامه رجل يقرأ سورة الكهف حتّى إذا بلغ إلى قوله تعالى:( أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَباً ) (2) . نطق الرأس بلسانٍ فصيح: «أعجب من أصحاب الكهف قتلي وحملي»(2) .
ولمّا أمر يزيد بقتل رسول ملك الروم حيث أنكر عليه فعلته، نطق الرأس الشريف بصوتٍ رفيع: «لا حول ولا قوة إلاّ بالله»(3) .
وحدّث ابن ليهعة: أنّه رأى رجلاً متعلقاً بأستار الكعبة يستغيث بربّه ثمّ يقول: ولا أراك فاعلاً. فأخذته ناحية وقلت: إنّك لمجنون! فإنّ الله غفور رحيم ولو كانت ذنوبك عدد القطر لغفرها لك. قال لي: اعلم كنت ممّن سار برأس الحسين إلى الشام، فإذا أمسينا وضعنا الرأس وشربنا حوله.
وفي ليلة كنت أحرسه وأصحابي رقود، فرأيت برقاً وخلقاً أطافوا بالرأس، ففزعت ودهشت ولزمت السكوت، فسمعت بكاءً وعويلاً، وقائلاً يقول: يا محمّد، إنّ الله أمرني أن أطيعك، فلو أمرتني أن أزلزل بهؤلاء الأرض كما فعلت بقوم لوط. فقال له: «يا جبرائيل، إنّ لي موقفاً معهم يوم القيامة بين يدي ربّي سبحانه».
____________________
(1) شرح قصيدة أبي فراس / 149.
(2) سورة الكهف / 9.
(3) الخصائص - السيوطي 2 / 127.
(4) مقتل العوالم / 151.
فصحت: يا رسول الله، الأمان. فقال لي: «اذهب فلا غفر الله لك». فهل ترى الله يغفر لي(1) ؟
وفي بعض المنازل وضعوا الرأس المطهّر فلم يشعر القوم إلاّ وقد ظهر قلم حديد من الحائط وكتب بالدم:
أترجو أمّةٌ قتلت حسيناً |
شفاعةَ جدّه يومَ الحسابِ(2) ؟ ! |
وقبل أن يصلوا الموضع بفرسخ وضعوا الرأس على صخرة هناك، فسقطت منه قطرة دم على الصخرة، فكانت تغلي كلّ سنة يوم عاشوراء، فيجتمع الناس هناك ويقيمون المأتم على الحسين حولها، وبقي هذا إلى أيّام عبد الملك بن مروان، فأمر بنقل الحجر فلم يرَ له أثر بعد ذلك(3) .
وقد روى ابن قولويه في الكامل: أنّهم كانوا يسمعون نوح الجن في الليالي التي قُتل فيها الحسين (عليه السّلام)، ومن شعرهم:
أبكي ابنَ فاطمة الذي |
مِن قتلهِ شاب الشعرْ |
|
ولقتلِهِ زُلزلتموا |
ولقتلِهِ انخسف القمرْ |
____________________
(1) اللهوف / 98.
(2) مجمع الزوائد - لابن حجر 9 / 199، والخصائص - السيوطي 2 / 127، وتاريخ ابن عساكر 4 / 342، وتاريخ القرماني / 108، ومثير الأحزان / 53.
(3) نفس المهموم / 228، ونهر الذهب في تاريخ حلب 3 / 33، وكتاب الإشارات إلى معرفة الزيارات / 66.
وذكر ابن نما عن أبي حباب الكلبي قال: لمّا قُتل الحسين (عليه السّلام) ناحت عليه الجنّ فكان الجصّاصون يخرجون بالليل إلى الجبّانة فيسمعون الجنّ يقولون:
مسح الحسينُ جبينَهُ |
فله بريقٌ في الخدودِ |
|
وأبوهُ من أعلا قريـ |
ـشٍ جدُّه خيرُ الجدودِ |
ويشير أبو العلاء المعرّي إلى قتل الحسين واحمرار السماء حزناً عليه في قصيدة يقول مطلعها:
علّلاني فإنَ بيضَ الأماني |
فُنيتْ والظلامُ ليس بفانِ |
|
وعلى الدهرِ من دماء الشهيديـ |
ـنِ عليٍّ ونجلِهِ شاهدانِ |
|
فهما في أواخر الليل فجرا |
ن وفي أولياتهِ شفقانِ |
|
ثبتا في قميصه ليجيء الحشـ |
ـر مستعدياً إلىالرحمنِ |
وممّا هو معروف أنّ المسيح كانت له سلطة على الجن والأرواح وجند الملائكة، فقد كانت تأتمر بأمره (عليه السّلام) فتنقله بلمحة طرف إلى أي مكان، ويأمرها فتنفّذ له ما يأمرها به، وعندما تبكي الجن على مقتل الحسين، فإنّ في هذه الحكمة الأعجوبة لمعجزة خارقة أتي بمثلها لعيسى (عليه السّلام).
وإذا كنّا قد خلصنا إلى أوجه الشبه بين عيسى والحسين (عليهما السّلام)، وبين شهادتَيهما، والمعجزات الكونيّة الخارقة التي تلتهما مباشرة، فإنّا سنعرّج على أوجه الاختلاف القليل بين الشهيدَين العظيمَين.
حكمةُ اختلاف الشهادتين
جاء عيسى (عليه السّلام) إلى اليهوديّة مبشّراً بالعهد الجديد بعد أن فسدت الضمائر، وحرّفت السنّة، وسنّت الشريعة، وقامت دولة الأحبار والشيوخ والفرّيسيّين والصدوقيّين، وقد أيّده الله سبحانه وتعالى بمعجزات لم يؤيّد بمثلها نبيّاً قبله أو بعده.
وقد لخّص (عليه السّلام) بعثه إلى اُمّة لعبت بوصاياها وحرّفت شرائعها حسب أهوائها واضطهدت كلّ الرسل الذين جاؤوا لهدايتها، فقال: (فبمَن أشبّه هذا الجيل، ومَن يشبهون؟ يشبهون أولاداً قاعدين في الساحة يصيح بعضهم ببعض، زمّرنا لكم فلم ترقصوا، ندبنا لكم فلم تبكوا).
جاء يوحنا المعمدان لا يأكل خبزاً ولا يشرب خمراً فقلتم: إنّ به مسّاً من الشيطان. وجاء ابن الإنسان - المسيح - يأكل ويشرب، فقلتم: هو ذا رجل أكول سكّير صديق للعشّارين والخاطئين، بَيْدَ أنّ الحكمة قد برّها جميع
بنيها(1) .
وعيسى (عليه السّلام) اعتقله اليهود وعذّبوه وأهانوه وبصقوا عليه، وضفروا رأسه بإكليل شوك، وجلدوه وتهكّموا عليه، وسخروه بحمل صليبه على طريق الجّلجلة في فلسطين، وأخيراً قتلوه وطعنوا جنبه بحربة قبل أن يلفظ أنفاسه، وكانوا سيكسّرون رجليه لكنّهم وجدوه ميتاً فلم يفعلوا، لتتمّ الآية (لن يكسر له عظم)(2) .
والحسين (عليه السّلام) جاء في زمن كانت الديانة التي بشّر بها جدّه الكريم وليدة تحبو بعد أن حقّقت فتوحات عظيمة، وأخضعت بقوّة تعاليمها وأخلاقيّاتها الاجتماعيّة العظيمة الشرق والغرب. وعندما شبّ عن الطوق لمس ما يعتري اُمّة جدّه من انحلال وتكالب على الأطماع الدنيويّة بما يناقض بعثها، فكان عليه أن يتصدّى لهذا الأمر الجلل، فكانت مهمّته أعمق غوراً، ورسالته أكثر تعقيداً من رسالة عيسى (عليه السّلام)، سيّما إذا نظرنا إلى نوعيّة الوسائل التي كانت بين يدَيه؛ إذ كما سبق وذكرنا لم تكن للحسين صفة نبويّة، بل كان عليه أن يلجأ إلى الوسائل البشريّة التي تسيّرها قوّة إلهيّة؛ وما ذلك إلاّ لكي تؤدّي رسالته الهدف المنشود منها، إذ لو جرت رسالته مجرى رسالة عيسى لما كان لها هذا الوقع المفجع، ولو قُتل وحده كما قُتل عيسى وحده لمّا كانت واقعة قتله لتؤجّج كلّ هذا التأنيب والشعور بالذنب والإحساس بالتقصير لدى كلّ مسلم.
وبرأيي أنّ ظرف اُمّة الإسلام في ذلك الزمن كان لا بدّ له من تضحية فائقة تقرب من التهلكة الجماعيّة؛ ليتسنّى لها الوقوف حيال تحلّل الاُمّة التي كان يتأكّلها من الداخل.
____________________
(1) لوقا 7 / 31 - 35.
(2) يوحنا 19 - 36.
إذاً فالظرفان مختلفان بين مجيء عيسى وبين مجيء الحسين، وبين ما أعدّته العناية الإلهيّة لكلّ منهما، وما زوّدتهما به من اختلاف السّبل والإمكانات، سواء ما كان قبل الشهادة أو بعدها.
والحسين (عليه السّلام) لم يسلم عظمه كما سلم عظم عيسى، بل إنّ ما حاقه فوق ثرى كربلاء المقدّس كان أعظم من احتمال البشر، بل كان من نوع يقرّب سيّد الشهداء إلى قائمة الرسل والنبيّين.
فأيّ رسول زرع في جسده أكثر من مئة نبلة وأكثر من أربعين طعنة، وأيّ نبي قتله العطش مثل ما فعل بالحسين (عليه السّلام)؟ وها هو أمير الشهداء وسيّدهم يُرمى بسهم في جبهته، ويُضرب بحجر فيها، ويُطعن على قلبه بسهم ذي ثلاث شعب، ويُرمى في حلقه، ويُضرب على عاتقه، ويُطعن في ترقوته وبصدره وبنحره وبجنبه، ويُسلب وتُقطع إصبعه من أجل خاتم، وتُقطع يده اليمنى ثمّ اليسرى من أجل تكّة سروال، ويُحتزّ رأسه الشريف، ويوطأ بعشر من الخيل صدراً وظهراً، ثمّ يُحمل رأسه على سن رمح إلى دمشق، حيث يوضع بمهانة أمام الفاسق يزيد لينكت ثناياه بالقضيب، ويعلّق في سوق الصيارفة ويشرب الخمر حوله، ويقال الكفر أمام كرامته.
فهل يبقى للمقارن المتمعّن في هذه الميتة الأليمة تردّد في وضع شهادة الحسين (عليه السّلام) في المقام الأوّل بين كل الشهادات التي ذكرها التاريخ؟
وإذا كانت قيمة الشهادة منوطة بما يتحمّله الشهيد من أذى، فإنّه لا مراء فيه أنّ الشهادة التي تمّت في صحراء كربلاء ذات قيمة عليا، لا تبلغها أيّة قيمة اُخرى لأيّة شهادة، لا سابقة ولا لاحقة.
وهي شهادة أكبر في مقياس المعاناة من شهادة عيسى (عليه السّلام) ولئن تعادلت معها في مقياس النتيجة، فإنّ لها وقع أشدّ على القلوب، وإذا تذكّرتها العقول فإنّ
لذكراها رنّة حزن وأسى تحفر في الحنايا والصدور أخاديد عميقة وأثلاماً لا تندمل.
وإذا كان غدر العدو متوقّعاً، ولا يثير وقوعه أيّة دهشة؛ فإنّ غدر القريب هو الغدر الأليم الوقع، والحسين غدره أقرب الناس إليه، وخذلته شيعته، وحاصرته وقتلته ومثّلت به جموع مسلمة محتسبة على دين محمّد، وقد حاربته باسم الإسلام الذي أنزل على جدّه الرسول محمّد (صلّى الله عليه وآله)، بينما قتل عيسى اليهود أعداء المسيحيّة، وعلى الرغم من قسوتهم وتسفيههم لرسول الإنسانيّة فإنّهم في مرآة الدمويّة والوحشيّة يبدون حملاناً وديعة بالمقارنة مع الذين قضوا على الحسين وآل بيته وأصحابه الأطهار.
فالوحشيّة التي شهدتها كربلاء ليس لها شبيه حتّى بين أشدّ الوحوش ضراوة، وكلمة (وحشيّة) لا تفيها حقّها من الدلالة عليها، فقد فاقت الوحشيّة بمراحل، وتقدّمت على الدمويّة بخطوات، وصار لزاماً أن يوجد لها تعبير يلائمها. لكن العقل البشري الذي وضع لكلّ مظهر حدوداً قصوى في الفعل والتعبير عن هذا الفعل، ولكلّ موقف أقصى ما يلائمه من كلمات تدلّل عليه، لم يستطع تخطّي تعبيري الوحشية والهمجيّة، مع أنّ الواقعة كانت تتخطّاهما بمراحل شاسعة.
ولعلّ خير شاهد على همجيّة ما جرى في كربلاء وبعدها هذه الحادثة الصغيرة في فعلها، الكبيرة في مرماها، والتي تدلّ بشكل واضح على موت كلّ ضمير وإحساس بشري في نفس صاحبها، وتفاقم كلّ أنواع الخسّة والوحشيّة في وجدان فاعلها.
فها هو خولي بن يزيد الأصبحي يسرح برأس الحسين بأمر من ابن سعد، وقد غدا به إلى قصر الإمارة حيث قابل ابن زياد ووضع الرأس بين يدَيه وهو يقول:
املأ ركابي فضّةً أو ذهبا |
إنّي قتلتُ السيّدَ المحجّبا |
وخيرَهم مَن يذكرون النَّسبا |
قتلتُ خير الناس اُمّاً وأبا(1) |
هذا المسلم بالاسم الذي عافه الإسلام، يفخر بكلّ الخسّة التي يمكن أن يعمر بها قلب بشري، بأنّه قتل السيّد المحجّبا، وقضى على خير الناس اُمّاً وأباً، ويفتح باب نفسه التي باعها للشيطان ينتظر الفضّة والذهب.
ولكنّ ابن زياد الذي لا يقلّ عنه خسّة وضعة يستاء من قوله أمام الجمع، فيجيبه: إذا علمت أنّه كذلك فلِمَ قتلته؟ والله لا نلت منّي شيئاً.
وفي إجابته هذه لا يأخذنّ بك الظنّ أيها القارئ على أنّ ابن زياد قد تحرّك ضميره للحظات فنطق لسانه بما نطق.. لا، بل هو اغتاظ من وصف خولي أمام الجميع بأنّه قتل خير الناس اُمّاً وأباً، في وقت كان ينتظر منه أن يصف ويطنب ويلفّق ويسبّ على الحسين أمامه وأمام الجمع المستمع؛ لذا فقد حجب عنه الجائزة التي كان ينتظرها.
وتتالت المعجزات الخارقة بعد شهادة الحسين (عليه السّلام)، ولعلّ معجزات الطبيعة هي أبسطها، فالمعجزات الحقّة كانت تلك التي قلبت اُمّة الإسلام رأساً على عقب بعد فترة من الزمن، وسنأتي على ذكرها في مكان آخر من الكتاب.
وكانت المعجزات التي أنزلها الله تعالى بعد استشهاد عيسى والحسين (عليهما السّلام)، البدايات الأولى المادّية؛ لِما سيلي بعدها من معجزات على مستوى الروح والعقيدة
____________________
(1) اختلف المؤرّخون بقائل هذه الأبيات. فعند ابن جرير الطبري / 261، وابن الأثير / 33 إنّه سنان بن أنس، أنشدها على عمر بن سعد، وفي شرح المقامات للشربشي / 193 أنّه أنشدها على ابن زياد، وفي كشف الغمّة للأربلي، ومقتل الخوارزمي / 40 أنّ بشر بن مالك أنشدها على ابن زياد، وفي رياض المصائب / 437 أنّ الشمر قائلها، وفي العقد الفريد / 213 سمّاه خولي بن يزيد الأصبحي وقد قتله ابن زياد لقوله الأبيات.
والصراط، مما يدلّ دلالة واضحة على أن الأنبياء والشهداء إنما اُوذوا وصبروا من أجل أن يكشف سبحانه وتعالى للبشر قضايا الحقّ الاُولى، وأن يبرزها لبصائرهم، ويعلنها لهم على اختلاف أديانهم. على أنها قضايا واحدة لا تنفصم، وهي لا تتغير؛ لأنّ ناموس الطبيعة البشرية لا يتغير؛ ولأنّ السرّ الإلهي كلٌّ لا يتجزأ.
وعندما ينيخ الضعف على النفوس فتغدو العقيدة ضعفاً لا يتّصل بقوة، بعد أن كانت قوة لا تتصل بالضعف، فإن المصلحين الشهداء ينبتون من بين المجتمع المتفكّك كما تنبت الشجرة الخيّرة من بين العليق؛ فيشدّون على عوامل الضعف، وينشطون العقيدة بنفحة من روح تضحياتهم التي تختتم دوماً بالجود في نفوسهم بعد أن يكونوا قدّموا لوحاً جديداً لدستور أخلاقي تتفتح عليه البصائر المعمية فجأة بعد استشهادهم، فتبدأ كيمياء هذا الدستور تفعل فعلها في النفوس والضمائر حيث مكامن العقيدة؛ فتصلح العقائد وتسمو القلوب، وتدعم الشهادة التي أطلقت هذا الدستور بشهادات تليها وتشابهها قوة وعنفواناً. وإذا بانتفاضة الإيمان الجديدة تتأجج كلهب البراكين التي سدّت عليها المنافذ قروناً فتفجّرت بغتة بفعل زلزال مُخلخل.
ولم تكن ثورة فرخ النبي (عليه السلام) إلا هذا الزلزال الذي خلخل كيان الاُمة الإسلاميّة، فصدّع مداميك انحرافها، وردم فجوات إيمانها، فبدت بعده ناصعة متماسكة مغسولة بزوفى الشهادة، ومعمّدة بدم الطُّهر الذي جعلها بيضاء كالسوسن، ونقية كالزنبق، وشفافة كوردة في صباح مشرق.
معجزات الشهادة في ضمير الإسلام
ليتَ أشياخي ببدر شهدوا |
جزعَ الخزرجِ من وقع الأسلْ |
|
لأهلّوا واستهلوا فرحاً |
ثم قالوا يا يزيدُ لا تُشلْ |
|
قد قتلنا القرمَ من ساداتِهمْ |
وعدلناهُ ببدرٍ فاعتدلْ |
|
لَعبتْ هاشمُ بالمـُلكِ فلا |
خبرٌ جاء ولا وحيٌ نزلْ(1) |
____________________
(1) بعض المؤرّخين كالخوارزمي وابن أبي الحديد في شرح النهج / 383، وابن هشام في واقعة اُحد ذكروا أن عدد هذه الأبيات ستة عشر بيتاً، وليس فيها ما ذكره ابن طاووس إلاّ الأوّل والثالث. وكان عجز الثالث في روايتهم (وعدلنا مَيل بدر فاعتدل )، وفي رواية أبي علي القالي في الأمالي / 142، والبكري في شرحه / 387،وأقمنا ميل بدر فاعتدل.
هذه مقولة يزيد أمام ركب السبي في دمشق، وأمام رأس الحسين الطاهر، وهي مقولة تدلّ على سدرة يزيد في كبريائه وغروره الذي عُرف به، وكان يتمنّى لو أنّ أشياخه الذين قضوا ببدر شهدوا انتصاره هذا، ويتنبّأ بأنّهم سيهلّون ويستهلّون فرحاً، ويباركون يمينه ويدعون لها بألاّ تشلّ على تعديل ميزان بدر بكربلاء.
وكانت مقولة فيها من غفلة المتغافل الشيء الكثير، يقابلها في الوعي المستشفّ للغد، خطبة العقيلة زينب المستلهمة عن لسان أبيها أمير المؤمنين (عليه السّلام): الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على رسوله وآله أجمعين، صدق الله سبحانه حيث يقول:( ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُون ) (1) .
أظننت يا يزيد، حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الاُسارى، أنّ بنا على الله هواناً وبك عليه كرامة، وأنّ ذلك لعظم خطرك عنده، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسروراً حين رأيت الدنيا لك مستوسقة، والاُمور متّسقة، وحين صفا لك مُلكنا وسلطاننا، فمهلاً مهلاً، أنسيت قول الله تعالى:( وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ ِلأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْماً وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ) (2)(3) .
وكأنّ زينب في ردّها المفحم على يزيد الآثم كانت تصوّر له مستقبل الأيّام وما يخبّئه الغد لبني اُميّة من مخاز ونهايات، وتعرض أمام الحضور الجانب الواعي المستشرف لموقف يزيد المتغافل المتعامي عن رؤية الحقائق كما ستكون في القريب العاجل.
ولم تطلّ فرحة يزيد؛ إذ لم تنقضِ سوى ساعات معدودة على ذيوع الخبر في بيته
____________________
(1) سورة الروم / 10.
(2) سورة آل عمران / 178.
(2) جاء ذكر هذه الخطبة في بلاغات النساء / 21، ومقتل الخوارزمي 2 / 64.
قبل أن ينتشر في عاصمة ملكه وباقي الأنحاء الإسلاميّة، حتّى كانت نساؤه تنحنِ مشفقات من هول ما بلغهنّ، وابن الحكم ينعى فعلة ابن زياد ويقول: حُجبتم عن محمّد يوم القيامة، لن اُجامعكم على أمر أبداً. وابنه معاوية يبكي، وإذا سُئل عن بكائه كان يجيب: نبكي على بني اُميّة لا على الماضين من بني هاشم.
وكانت أوّل صرخة لَوم وتأنيب بعد الشهادة أطلقتها زينب (عليها السّلام) في الكوفة، فاهتزّت لها الضمائر واستيقظت، وما قالته زينب ابنة علي للجموع الملتفّة حول ركب السبي له وَقْع الفجيعة ولائمة التقصير: الحمد لله والصلاة على أبي محمّد وآله الطيبين الأخيار.
أمّا بعد، يا أهل الكوفة يا أهل الختل والغدر، أتبكون؟! فلا رقأت الدمعة، ولا هدأت الرّنة، وإنّما مَثَلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوّة أنكاثاً، تتخذون أيمانكم دَخَلاً بينكم، ألا وهل فيكم إلاّ الصّلف النّطف؟! والعجب والكذب والشنف وملق الإماء وغمز الأعداء، أو كمرعى على دمنة، أو كقصّة على ملحودة، ألا بئس ما قدّمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم، وفي العذاب أنتم خالدون!
وما أن سمع الجمع هذا القول حتّى أخذتهم العَبرة، ونشجوا في بكاء شديد وقد لمس كلام زينب (عليها السّلام) شغاف ضمائرهم، بينما أردفت (عليها السّلام) مكمّلة وسط نهنهاتهم ولومهم لأنفسهم، فقالت: أتبكون وتنتحبون؟! أي والله، فابكوا كثيراً واضحكوا قليلاً فلقد ذهبتم بعارها وشنارها، ولن ترحضوها بغسل بعدها أبداً. وأنّى ترحضون؟! قتل سليل خاتم النبوّة ومعدن الرسالة، ومدرة حجّتكم ومُنى محجّتكم، وملا خيرتكم ومفزع نازلكم وسيذّد شباب أهل الجنّة؟ ألا ساء ما تزرون.
فتعساً ونكساً وبُعداً لكم وسحقاً! فلقد خاب السعي، وتبّت الأيدي، وخسرت الصفقة، وبؤتم بغضب من الله ورسوله، وضربت عليكم الذلّة والمسكنة.
ويلكم يا أهل الكوفة! أتدرون أيّ كبد لرسول الله فريتم؟ وأيّ كريمةٍ له أبرزتم؟ وأيّ دمٍ له سفكتم؟ وأيّ حرمةٍ له انتهكتم؟ لقد جئتم شيئاً إدّا، تكاد السموات يتفطّرن منه، وتنشقّ الأرض، وتخرّ الجبال هدّا. ولقد أتيتم بها خرقاء شوهاء كطلاع الأرض وملء السماء، أفعجبتم أن مطرت السماء دماً؟ ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فلا يستخفّنكم المهل؛ فإنّه لا يحفزه البدار، ولا يخاف فوت الثأر، وإنّ ربّكم لبالمرصاد(1) .
وكان خطاب العقيلة المؤنّب ردّ فعل عنيف بين الحشد المعمى بصيرته بالخداع والمطامع، فحرّكت مكامن الخير في ضميره، فأحسّوا بما جنوا، وضربتهم حيرة أمام بلاغة العقيلة، فما حاروا إجابة.
وأمام بلاغة زينب (عليها السّلام) والتي تتالت لتوقظ الضمائر في مواقف شتّى، تتبدّى حكمة الله تعالى الذي أوحى للشهيد الحسين (عليه السّلام) بإشراك نساء آل البيت في ثورته، إذ ما توجّهن إلى دمشق حتّى بدأن حربهنّ النفسيّة بالكلمة البليغة والبيان المؤثّر، مكمّلات وثبة أسد كربلاء، ومواصلات إيصال صرخته في فلاتها: «أما من مغيثٍ يغيثنا، أما من ناصرٍ يعيننا».
فتتواصل بعدها استجابات الضمائر النائمة، كما استجابت ضمائر الأنصاريَين سعد بن الحارث وأخيه أبي الحتوف لصرخة الحسين، فاستنصراه مستجيبين لها حتّى قُتلا.
____________________
(1) ورد ذكر الخطبة في أمالي الشيخ الطوسي، واللهوف، وابن نما، وابن شهر آشوب، واحتجاج الطبرسي.
فإذا قيل في الإسلام: بدؤه محمدي وبقاؤه حسيني، فالأجدر أن يقال أيضاً: ثورة الحسين بدؤها حسيني واستمرارها زينبي(1) .
إذ ما كادت هذه الثورة المباركة تضع أوزارها عسكرياً بتساقط رؤوس آل البيت وسبي الحرائر والعقيلات والأطفال إلى دمشق، حتّى هبّت عقيلة بني هاشم، التي قيل فيها العالِمة غير المعلّمة، والفاضلة والكاملة، وعابدة آل علي، هبّت إلى استلام راية الثورة الحمراء من يد أخيها الحسين (عليه السّلام) ورفعتها فوق رؤوس الخلق بما علق عليها من دماء آل بيت النبي، وهتفت من تحتها ترثي أخاها الذبيح في فلاة كربلاء الموحشة:
على الطّفِّ السلامُ وساكنيهِ |
وروحُ الله في تلك القبابِ |
|
نفوسٌ قُدّست في الأرض قدساً |
وقد خُلقتْ من النُّطفِ العِذابِ |
|
مضاجعُ فتيةٍ عبدوا فناموا |
هُجوداً في الفدافدِ والروابي |
|
علتهمْ في مضاجعِهمْ كعابٌ |
بأردانٍ مُنعّمةٍ رِطابِ |
|
وصيّرتِ القبورَ لهم قصوراً |
مناخاً ذاتَ أفنيةٍرحابِ (2) |
____________________
(1) هذا التعبير من وضعنا، وقد قصدنا به التركيز بإيجاز على دَور العقيلة زينب الذي لا يقلّ عن دور أخيها (عليه السّلام).
(2) بطل العلقمي 3 / 335.
سليلةُ بيت النبوّة
وزينب الكبرى (عليها السّلام) سليلة أشرف نسب في الإسلام، فاُمّها فاطمة الزهراء بنت رسول الله (صلوات الله عليهما)، وأبوها أمير المؤمنين (عليه السّلام)، وقد ولدتها اُمّها بعد ولادة أشرف شهيدَين، سيّدا شباب أهل الجنّة الحسنين (عليهما السّلام)، فنشأت في بيت الوحي بعد أن رضعت القدسيّة من ثدي العصمة، ونهلت العلم والحِلم ومكارم الأخلاق وكلّ الخصال الحميدة التي اشتهرت عن آل البيت، وهي لمّا تزل صغيرة.
وقد أثبتت حوادث ما بعد الشهادة ومواقفها خلال فترة السبي، على رجاحة عقلها وقوّة حجّتها وحضور وحيها في أشدّ لحظات الخطر وأصعبها، إذ قادت بنفسها مسيرة ما تبقّى من الموكب، ودافعت عنه دفاع اللبوة عن أشبالها، فغدت مواقفها على مرّ الأيّام وتعاقب القرون مثالاً يحتذى به، وفخراً لثورة أخيها التي أكملتها بجهادها المستميت.
وقد ذكر الطبرسي أنّها (عليها السّلام) كانت شديدة الحبّ لأخيها الحسين منذ نعومة أظفارها، وكأنّ السرّ الإلهي كان يعدّهما لهدفٍ واحد يتقاسمان أعباءه. وهذا ما أكّده تواتر الأيّام؛ إذ شاركته مسيرته وكانت إلى جانبه في معمعان محنته، ولمّا سقط خرجت من فسطاطها ووقفت عند جسده ثمّ رفعت رأسه وقالت: اللّهم تقبّل منّا هذا القربان(1) .
وقيل: إنّها كانت قد وطّنت نفسها عند إحراق الخيم أن تقرّ في الخيمة مع النسوة، إن كان الله شاء إحراقهنّ كما شاء قتل رجالهنّ، وقد سألت زين العابدين عند اضطرام النار: يابن أخي، ما نصنع؟ مستفهمة منه مشيئة الله فيهنّ.
____________________
(1) الكبريت الأحمر 3 / 13 عن الطراز المذهّب.
إنّها الروح المؤمنة ذاتها التي رفعت هتافها فوق جسد الحسين الطاهر، وتضرّعت لله أن يقبله كقربان، صرخت أمام يزيد الفاسق: أمن العدل يابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهنّ، وأبديت وجوههن، وصَحِلت أصواتهن، تحدو بهنّ الأعداء من بلدٍ إلى بلد، ويستشرفهنّ أهل المناهل والمناقل، ويتصفّح وجوههنّ القريب والبعيد، والشريف والدني، ليس معهنّ من رجالهنّ ولي، ولا من حماتهنّ حمي؟!
وكيف ترتجى مراقبة ابن مَن لفظ فوه أكباد الأزكياء، ونبت لحمه من دماء الشهداء؟! وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت مَن نظر إلينا بالشنف والشنآن، والإحن والأضغان؟! ثمّ تقول غير متأثّم ولا مستعظم داعياً بأشياخك: ليت أشياخي ببدر شهدوا! منحنياً على ثنايا أبي عبد الله سيّد شباب أهل الجنّة تنكتها بمحضرتك.
وكيف لا تقول ذلك؟! وقد نكأت القرحة واستأصلت الشّافة بإراقتك دماء ذرّية محمّد (صلّى الله عليه وآله)، ونجوم الأرض من آل عبد المطّلب، أتهتف بأشياخك؟! زعمت أنّك تناديهم فلترِدَنّ وشيكاً موردهم، ولتودّنّ أنّك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت، وفعلت ما فعلت. اللّهمّ خذ لنا بحقّنا وانتقم ممَّن ظلمنا، واحلل غضبك بمَن سفك دماءنا وقتل حماتنا.
فوالله يا يزيد ما فريت إلاّ جلدك، ولا حززت إلاّ لحمك، ولترِدَنّ على رسول الله بما تحمّلت من سفك دماء ذريّته وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته، حيث يجمع الله شملهم ويلمّ شعثهم ويأخذ بحقّهم،( وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ) (1) . وحسبك بالله حاكماً، وبمحمّد (صلّى الله عليه وآله) خصيماً، وبجبريل ظهيراً. وسيعلم مَن سوّل لك ومكّنك من رقاب المسلمين، بئس للظالمين بدلاً! وأيّكم شرّ مكاناً وأضعف جنداً!
____________________
(1) سورة آل عمران / 169.
ولئن جرت عليّ الدواهي مخاطبتك، إنّي لأستصغر قدرك، وأستعظم تقريعك، وأستكثر توبيخك، لكنّ العيون عبرى والصدور حرّى، ألا فالعجب كلّ العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء وهذه الأيدي تنطف من دمائنا والأفواه تتحلّب من لحومنا، وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل وتعفّرها اُمّهات الفراعل(1) ، ولئن اتّخذتنا مغنماً لتجدننا وشيكاً مغرماً حين لا تجد إلاّ ما قدّمت يداك وما ربّك بظلاّمٍ للعبيد.
فإلى الله المشتكى وعليه المعوّل، فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا، ولا تميت وحينا، ولا تدرك أمدنا، ولا يرحض عنك عارها، وهل رأيك إلاّ فند وأيّامك إلاّ عدد، وجمعك إلاّ بدد، يوم ينادي المنادي: ألا لعنة الله على الظالمين؟ فالحمد لله ربّ العالمين، الذي ختم لأوّلنا بالسعادة والمغفرة، ولآخرنا بالشهادة والرحمة، ونسأل الله أن يكمل لهم الثواب ويوجب لهم المزيد، ويحسن علينا الخلافة، إنّه رحيم ودود وهو حسبنا ونِعم الوكيل.
هذه البلاغة والفصاحة لا يأتي بمثلها إلاّ مَن تربّى في بيت الطالبيّين، وهذه الشجاعة الفائقة لا يجسر عليها بشرٌ حيال يزيد، وقد جسرت عليها الحوراء، فبلبلت مجلس يزيد وأحدثت في أركانه هزّة، فلم يزد إلاّ أن قال:
يا صيحةً تُحمدُ من صوائحِ |
ما أهونَ النوح على النوائحِ |
ثمّ أمر بإخراج الحرم من المجلس إلى خربة، حيث أقاموا فيها ثلاث أيّام يندبون وينوحون على الحسين (عليه السّلام)(2) .
____________________
(1) العواسل: جمع عسّال، وهو الذئب. والفراعل: جمع فرعل، وهو ولد الضبع.
(2) اللهوف / 207، وأمالي الصدوق / 101.
وإنّها لحكمة إلهيّة أن يسار بالسبي إلى الكوفة ودمشق بهذا الشكل المهين على أقتاب الجمال، فيرى الناس في السبايا من الفجيعة أكثر ممّا رأوا أو سمعوا في قتل الحسين، وهذا ما هدف له الشهيد بخروجه بالنساء والأطفال والرضّع ليكونوا شهوداً وألسنة تنطق بمظلمته.
وقد قامت العقيلة زينب بالدَور الأكبر في ثورة أخيها الحسين بحملها لواء الحرب النفسيّة التي تمّمت حرب أخيها العسكريّة، وشكّلت معها الوجه الآخر لهدفٍ واحد ألا وهو إحقاق الحقّ، وتقويض الدولة الاُموية التي مثّلت انتهاك السنّة وتحريف العقيدة، وفساد الحكم في كلّ زمان ومكان.
ولو لَم تقم زينب (عليها السّلام) بدَورها الصعب الذي قامت به لَما زادت الواقعة ونتائجها عن واقعة ونتائج أيّة معركة تدار فيها الأيدي والسّيوف، وتصهل فيها الخيل، والرأي الأمثل في هذه الحكمة - حكمة خروج الحسين بحرمه وما تلاها من استلام زينب لراية الكفاح - إنّما كان هو الهدف الذي سيتحقق بعده كلّ أهداف الثورة؛ إذ لولا خروج زينب وحرائر وعقيلات آل البيت هذا الخروج الدرامي المفجع لَما كان للهزّة الضميريّة هذا التوجّع المؤلم، ولم يكن ليتسنّى لها الدخول على ابن زياد في قصر الإمارة لتعلن أمام الحشد صرختها التي هي في مضمونها صرخة مشتركة مع صوت أخيها الحسين (عليه السّلام)، فتقول: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيّه محمّد، وطهّرنا من الرجس تطهيراً، إنّما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا(1) .
ولا كان بإمكانها الوقوف أمام يزيد وهو فوق متّكئ سلطانه وجبروته وإلقاء خطبتها البليغة التي تحمل عبق الصدق، فتتآلف لها النفوس، وتتألّب لها الضمائر وتتوغّر معها الصدور على يزيد وطغمته، فتكون بذلك قد بذرت بذرة الثورة في
____________________
(1) تاريخ الطبري 6 / 262، واللهوف / 90.
الصدور إلى أن يحين موعد انفجارها.
وسيّد الشهداء (عليه السّلام) كان ينظر إلى المستقبل نظرته إلى كتاب مفتوح، وكان عالِماً بأنّ خذلان شيعته لن يدوم أبد الدهر، وكان في خروجه وإخراج الحرم معه إنّما يراهن على حيويّة الضمائر الإسلاميّة التي لن تجد مندوحة ولا أعذاراً في لوم نفسها على التقصير، سواء عن سكوتها على مباغي الاُمويّين، أم في عدم نصرتها للثائر الحسين الذي قام يحطّم الوثنيّة الجاهليّة الجديدة التي امتطت الإسلام لتحقيق مآربها، ومحقت ذريّة الرسول صاحب هذه الرسالة باسم خلافة مزيّفة.
المعجزةُ الروحيّة
وهذه معجزة اُخرى من معجزات شهادة الحسين (عليه السّلام) معجزة تتّصل بالضمائر بمنفصم وثيق العرى، فتمسّها مسّاً مباشراً، فتتكهرب وتستيقظ على أمرٍ جلل قد وقع وهي لا مناص لها من التبصّر في كيفيّة وقوعه.
وعلى أنوار الشهادة السنيّة يتكشّف لهذه الضمائر ظروف تقصيرها، وبأنّها كانت غافلة نائمة مخدّرة بأطماع وقتيّة، وعلى صوت الحقّ الذي رفعته السبايا، تصحو العيون والقلوب والأسماع، فترى ما عميت عنه، وما تغافلته زمناً، وما امتنعت عن سماعه ردحاً.
وهذه المعجزة وما تلاها، بدأت بخطبة زينب الاُولى في الكوفة، وكهربتها للجموع التي أطلقت لعبرها العنان، وقد بانت عظمة هذه المعجزة التي حملتها وستكمل حملها الكلمات القدسيّة المحاجّة التي اختصّ الله بها أهل بيت النبوّة، والتي بدأت في الميدان وعلى لسان الشهيد نفسه حينما دوى صرخته التي
استمرّت حتّى وقتنا هذا تتردّد في الضمائر: «أما من مغيثٍ يغيثنا؟ أما من ناصرٍ يعيننا؟».
وقد لبّى استجابة الصرخة الحسينيّة الحرّ بن يزيد الرياحي الذي توجّه نحو الشهيد رافعاً صوته نادماً على خروجه لقتاله: أللّهم إليك اُنيب فتُب عليَّ، فقد أرعبتُ قلوب أوليائك وأولاد نبيّك، يا أبا عبد الله إنّي تائب، فهل لي من توبة؟(1) .
فهذه اللحظات التي تمثّل رجعات الضمير من جبّ مآثمه، كان الحسين (عليه السّلام) يعوّل عليها كثيراً في إيصال مبادئ ثورته، وقد حملت زينب (عليها السّلام) عبء مهمة إيقاظ الضمائر تأهّباً لرجعتها، ساعدها في ذلك مشهد السبي المحزن الذي كان يفتّت أشدّ القلوب صلابة.
استجاباتٌ فوريّة
فعن كتاب (المنتخب): أنّ عبد الله بن زياد دعا شمر بن ذي الجوشن، وشبث بن ربعي، وعمرو بن الحجاج، وضمّ إليهم ألف فارس وأمرهم بإيصال السبايا والرؤوس إلى الشام.
وقال أبو مخنف: مرّ هؤلاء في طريقهم بمدينة (تكريت) وكان فيها عدد من النصارى، فلمّا حاولوا أن يدخلوها اجتمع القسّيسون والرّهبان في الكنائس وضربوا النواقيس حزناً على الحسين، وقالوا: إنّا نبرأ من قوم قتلوا ابن بنت
____________________
(1) اللهوف / 58، أمالي الصدوق / 97، روضة الواعظين / 159.
نبيّهم، فلم يجرؤوا على دخول المدينة، وباتوا ليلتهم في البريّة، وكانوا يقابلون بالإعراض والكراهية كلّما مرّوا بدير من الأديرة أو بلد من بلدان النصارى.
ولمّا وصل الركب إلى (لينا) وكانت مدينة كبيرة تظاهر أهلها رجالاً ونساءً وشيباً وشبّاناً وهتفوا بالصلاة على الحسين وجدّه وأبيه، ولعنوا الاُمويّين وأشياعهم وأتباهم، وصرخوا في وجوه قوّاد الركب: يا قتلة أولاد الأنبياء، اُخرجوا من مدينتنا.
ولمّا حاذوا (جهينة) بلغهم أنّ أهلها تجمّعوا وتحالفوا على قتالهم إذا وطؤوا أرض بلدهم، فتراجعوا عن دخولها. وأتوا حصن (كفر طاب) فأغلق أهلها الأبواب في وجوههم، فطلبوا منهم ماء، فردّ عليهم أهل الحصن: والله لا نسقيكم قطرة، وأنتم منعتم الحسين وأصحابه من الماء.
ولمّا دخلوا حمص كانت واقعة كبرى إذ تظاهر أهلها وصاروا يردّدون: أكفراً بعد إيمان، وضلالاً بعد هدى؟! وهجموا عليهم فقتلوا 36 فارساً رشقاً بالحجارة.
وكأنّ عقيلة بني هاشم تستقرئ المستقبل وهي واثقة من ارتداد الضمائر، إذ قالت وهي مسبيّة: المستقبل لذكرنا، والعظمة لرجالنا والحياة لآثارنا والعلوّ لأعتابنا والولاء لنا وحدنا. فسبحان المنطق القادر على إيصال الوحي إلى عقول ما جال بها إلاّ الحق، ومسيّره على ألسنةٍ ما نطقت إلاّ بالفصاحة القرآنيّة، إذ بلغ الأمر بيقظة الضمائر بعد انتهاء المذبحة بالمقتل وعودة السبي والدفن أن صارت حممها تتأجّج وتعلو لتنير كلّ ما حولها، وإذا بالولاء لأهل البيت سنّة سنّها الناس لأنفسهم، والتبرّك بعتباتهم العالية صار فرضاً على كلّ مؤمن، وذِكرهم يحيا سنةً
بعد أخرى وجيلاً بعد جيل، ومناقبهم تعلن من فوق المنابر، ومزاراتهم وقبورهم وكلّ مكان وطؤوه صارت محجّات للملايين من اُمّة الإسلام تحجّ إليها ضارعة مستغفرة، قارعة الصدور ندماً، ذائبة على آل البيت حبّاً من كلّ فجٍّ عميق.
وهذه إحدى معجزات الشهادة وما تلاها من خوارق أنزلها الله تعالى في الضمائر، فكيف استمرّت نيران هذه الشرارة التي قدحها سيّد الشهداء فوق أرض خلاء لا يراه فيها أحد، كيف استمرّت وتأجّجت وفردت سناها فوق رؤوس الخلائق في وقت انطفأت فيه نيران متأجّجة كثيرة؟
أليست معجزة الخالق التي خطّطت لهذه الثورة بهذه الكيفية، وما قول اُولئك الذين ما زالوا بعد كلّ هذا الفيض من الانتصارات الذي أحرزته ثورة فرخ النبي، يتصدّون لها بمقاييس تقليديّة تبعد بها أميالاً عن حقيقة جوهرها؟
إلاّ أنّ هذه الثورة رغم ما تعرّضت له على مرّ السنين من مغالطات وتشويه وتحريف ما ازدادت إلاّ سطوعاً وعلوّاً. وهذا ما تنبّأت به زينب (عليها السّلام) فيما قالته لابن أخيها الإمام السجّاد قبل أن يترك الركب أرض كربلاء في الحادي عشر من محرم: ما لي أراك تجود بنفسك يا بقيّة جدّي وأبي وإخوتي؟ فوالله إنّ هذا لعهد من الله إلى جدّك وأبيك، إنّ قبر أبيك سيكون علماً لا يُدرَس أثره، ولا يُمحى رسمُه على كرور الليالي والأيّام، وليجتهد أئمّة الكفر وأشياع الضلال في محوه وتطميسه، فلا يزداد أثره إلاّ علوّاً(1) .
وهكذا شاءت العناية الإلهيّة أن تكون السيّدة الحوراء شاهدة على المجزرة التي لم
____________________
(1) كامل الزيارات / 261 باب فضل كربلاء وزيارة الحسين.
يكن فيها خصمان، بقدر ما كان فيها قاتل ومقتول، وجزّار وضحيّة، وأن تكون مواقفها وكلماتها بعد المجزرة مواقف وكلمات المُعايِنَة، المُعانِيَة بكلّ أعصابها وإحساسها النسوي الاُمومي، ولم يكن كزينب أهلٌ لهذه المهمّة الصعبة تناط بها، وهي التي شاهدت وفاة جدّها الرسول (صلّى الله عليه وآله)، وعاشت محنة اُمّها الزهراء وندبها لأبيها في بيت الأحزان وانتهاك حرمتها ومنع إرثها وكسر جنبها وإسقاط جنينها وتلطيخ سمعتها وهي تنادي فلا تُجاب.
وهي التي شاهدت قتل أبيها أمير المؤمنين (عليه السّلام)، ورأت مكان الضربة في رأسه، وعاينت مظاهر سريان الدم في جسده، واحترقت بدموعه الطاهرة تفيض من عينَيه، وهو يقلّب طرفه فيها وبأخويها الحسن والحسين (عليهما السّلام). وهي التي شاهدت أخاها الحسن وهو يجود بنفسه مصفرّ اللون، يلفظ كبده قطعاً قطعاً من تأثير السمّ، ورأت عائشة تمنع من دفنه مع جدّه وتركب بغلة وتصيح: والله لا يُدفن الحسن هنا أبداً.
أمّا مصيبة المصائب وخاتمة الأرزاء التي عاشتها ورأتها فكانت فيما عاشته إلى جانب أخيها الشهيد في كربلاء، وفيما عانته خلال مسار سبيها برفقة العليل والنساء والأطفال، كانت مصائب يعجز عن وصفها لسان، وأرزاء لا يحتملها بشر، فاقت في قوّتها وتأثيرها كلّ ما مرّ بها من محن وآلام في تتالي أيّامها المتخمة بالأحزان والمصائب. فكيف عاشت العقيلة هذه التجارب؟ وكيف تحمّلت كلّ هذه الآلام؟ وكيف صبرت على كلّ هذا القدر من البلاء الذي حلّ بها؟
المألوف هنا في مثل هذه المواقف أن تُتعتَع أشدّ العقول رزانة، وتعمى أشدّ البصائر رويَّة، فتتخبّط خبطاً عشواء تدلّ على اختلال الأعصاب التي لا تبقي على أي أثر للتعقّل أو الاتّزان.
فهل فَقَدت زينب (عليها السّلام) رباطة جأشها؟ هل ارتجّت أعصابها فاختلّ توازنها؟ هل تزعزعت ثقتها بنفسها وبإيمانها وبحكم ربّها؟ هل جدّفت أو رفعت رأسها إلى السماء تتساءل لِمَ هي دون غيرها يجب أن تتحمّل كلّ هذا؟ هل فَقَدت حسّ الاُمومة وإحساس القدسيّة والقدرة على التصرّف قولاً وفعلاً؟
أبداً، فإنّ شيئاً من ذلك لم يحدث، فابنة علي وفاطمة لم تتزعزع، حفيدة النبي (صلّى الله عليه وآله) لم تفقد إيمانها، اُخت الحسنَين لم تكفر بحكمة الله، بل ما زادتها المحن والآلام إلاّ ثبات جنان ورجاحة عقل واعتصاماً بحكمة الخالق وإذعاناً لمشيئته.
وارثة مبادئ علي (عليه السّلام)
ولا عجب، فهي غذيّة حكمة أبيها أمير المؤمنين، ووارثة مبادئ آل البيت التي لقّنها إيّاها أبوها وهي لمّا تزل طفلة تحبو، حيث كانت تسمعه يجاهر بهذا المبدأ الذي حفر في وجدانها الغض: «إنّ أشدّ الناس بلاءً النبيّون، ثمّ الوصيّون، ثمّ الأمثل فالأمثل، وإنّما يُبتلى المؤمن على قدر أعماله الحسنة. فمَن صحّ دينه وحسن عمله، اشتدّ بلاؤه؛ ذلك أنّ الله لم يجعل الدنيا ثواباً للمؤمن ولا عقوبة للكافر. ومَن سخف دينه ضعف عمله وقلّ بلاؤه، وأنّ البلاء أسرع إلى المؤمن التقي من المطر إلى قرار الأرض».
وإذا كنّا قد تكلّمنا حتّى الآن عن معجزات الشهادة الروحيّة التي ردّت إلى
الضمائر إحساسها البشري، وجعلتها تقف على فداحة تقصيرها تجاه الحسين (عليه السّلام) ودَور زينب (عليها السّلام) في إزكاء الحميّة في الرؤوس، وإيقاظ النفوس الهاجعة وحمل لواء النفسيّة التي هي تتمّة للحرب التي نفّذها أخوها الحسين (عليه السّلام) فوق ثرى كربلاء، فإنّ لبقيّة عقيلات آل البيت أدوارهن المكمّلة لدور الحوراء في تبيان الحقيقة، وإثارة شعور الندم في القلوب.
فها هي فاطمة بنت الحسين (عليها السّلام) ما أن رأت عمّتها زينب (عليها السّلام) تنتهي من خطبتها في جموع الكوفة حتّى وقفت تخطب في هذه الجموع وتوضّح لها دَورها المتخاذل عن نصرة أبيها، وحقدها على رسالة النبي، وحذّرتهم ألاّ يشتطوا كثيراً في فرحتهم بما أصابوا من دمائهم، ونبّهتهم إلى توقّع اللّعنة والعذاب من السماء، ولعنة الظالمين منهم.
وما أن أتمّت خطبتها حتّى ارتفعت الأصوات بالبكاء والنحيب ندماً وحزناً، وصاحت الجموع بصوتٍ واحد: حسبكِ يابنة الطاهرين، فقد أحرقتِ قلوبنا وأنضجتِ نحورنا وأضرمتِ أجوافنا(1) .
وتلتها في اللوم والتقريع وإثارة الضمائر اُمّ كلثوم، فقرّعتهم على نزع الرحمة من قلوبهم، وحذّرتهم من لعنة الدماء الذكيّة التي سفكوها، ومن غضبة الله على قتلهم خير الرجالات بعد النبي.
فضجّ الجمع بالبكاء، ونشرت النساء شعورهنّ وخمشن وجوههنّ ولطمن خدودهنّ، ودعون بالويل والثبور، حتّى صار الجمع بين باكٍ ولاطمٍ.
____________________
(1) لقد ثبت علمياً أنّ مشاعر الغضب والحزن والندم، تُبدِّل كيماوية الجسم، فيشعر صاحبه بالحرقة في قلبه، والاكتواء في حجابه الحاجز، والتآكل في معدته.
بلاغة السجّاد (عليه السّلام)
ولمّا جيء بعلي بن الحسين (عليه السّلام) على بعير والجامعة في عنقه، والغلّ في يدَيه إلى عنقه، وأوداجه تشخب دماً، بادر الجمع بهذه الأبيات:
يا اُمّةَ السوءِ لا سُقياً لربعِكُمُ |
يا اُمّةً لم تراعي جدَّنا فينا |
|
لو أنّنا ورسولُ الله يجمعُنا |
يومَ القيامةِ ما تقولونا |
|
تُسيّرونا على الأقتاب عاريةً |
كأنّنا لم نشيّد فيكُمُ دينا |
وأومأ إلى الناس فسكتوا، بينما أخذ (عليه السّلام) يعرّفهم مَن هو قائلاً: «أيّها الناس، مَن عرفني فقد عرفني، ومَن لم يعرفني فأنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. أنا ابنُ مَن انتهكت حرمته وسُلبت نعمته، وانتهب ماله وسُبي عياله، أنا ابنُ المذبوح بشطّ الفرات من غير ذحل ولا ترات، أنا ابنُ مَن قُتل صبراً وكفى بذلك فخراً...».
ثمّ أخذ (عليه السّلام) يبيّن لهم كيف خانوا أباه بعد أن أعطوه من أنفسهم العهود والميثاق والبيعة، وقاتلوه. وسألهم بأيّة عين ينظرون إلى رسول الله بعد قتلهم لعترته وانتهاك حرمته؟ فارتفعت الأصوات ضاجّة بالبكاء وقالوا بأجمعهم: نحن يابن رسول الله سامعون مطيعون، حافظون لذمامك غير زاهدين فيك ولا
راغبين منك، فمُرنا بأمرك يرحمك الله؛ فإنّا حرب لحربك، وسِلم لسِلمك، نبرأ ممّن ظلمك وظلمنا.
ولكنّ الوقت كان قد فات، ولم يعد ينفع الندم، فردّ عليهم السّجّاد (عليه السّلام): «هيهات هيهات أيّها الغدرة المكرة! حيل بينكم وبين شهوات أنفسكم. أتريدون أن تأتوا إليّ كما أتيتم إلى أبي من قبل؟ كلاّ وربّ الراقصات؛ فإنّ الجرح لمّا يندمل، قُتل أبي بالأمس وأهل بيته، ولم ينسَ ثكل رسول الله وثكل أبي وبني أبي»(1) .
وكان لهذه الخُطَب ردّ فعل قويّ في النفوس فانفعلت معها انفعالاً عميقاً، كان كفيلاً ببعث الروح النضاليّة الهامدة في جذوة جديدة، وهزّ الضمائر الميّتة هزّات أحيتها، فكان أن خطت ثورة الحسين الوليدة اُولى خطواتها في الدرب الذي طمحت للسير فيه، ففتحت عيون الناس على زيف الحياة الروحيّة التي كانت تحتويهم.
وبدأ الإطار الديني المغلّف لحكم الاُمويّين باسم الإسلام يتزعزع ويتشقّق تمهيداً لانهياره القادم، وتنبّهت النفوس إلى الروح الجاهليّة التي تغلغلت في أركان الحكم، وبدأ الشعور بالإثم يتفاعل داخل القلوب، وبدأت معه اُولى خطوات نقد الذات وتقويم المجتمع لنفسه، والبحث عن مناقبية جديدة للإنسان المسلم بعد أن فقد إنسانيّته، فجاءت ثورة الحسين (عليه السّلام) لتنبّهه إلى فقدان هذه الإنسانيّة.
وقد ساهمت معركة الطّفِّ وحوادث السبي في إيقاد جذوة الإيمان من جديد في وجدان الاُمّة، ساعدها في ذلك ما ظهر من وحشيّة الاُمويّين في مناجزة الحسين وقتله مع نخبة كريمة من آله وصحبه (عليهم السّلام)، وما رافق ذلك من مظاهر البربريّة المتمثّلة في حمل
____________________
(1) كلّ هذه الخطب ذكرها ابن طاووس في اللهوف، وابن نما في مثير الأحزان.
الرؤوس على الحراب إلى دمشق، وما برهن ذلك على تجرّد الاُمويّين من كلّ نزعة دينيّة وإنسانيّة.
وكانت اليقظة الروحيّة لاُمّة الإسلام هي الاُعجوبة الخارقة التي تشكّل أساس كلّ المعجزات التي أتتها الشهادة فوق أرض كربلاء، والتي شكّلت فيما بعد المحوَر الذي دارت عليه المعجزات المتتالية الاجتماعيّة منها والزمنيّة.
إذ كما هو متّفق عليه في نظريّات علم النفس أنّ يقظة الضمير وتفتّح البصيرة بعد موات وهمود من شأنه أن يقلب حياة الإنسان رأساً على عقب، ويجعله يحطّم كلّ ما يحيط به ويذكّره بهوانه وتقصيره الذي أدّى به إلى ما وقع له أو به(1) .
ولعلّ ما زاد في تأجّج عامل الندم في نفوس المسلمين تلك الفرص التي أتاحها لهم الشهيد، سواء ما كان منها قبل المعركة أو خلالها، للكفّ عن قتاله وتلويث أيديهم بدماء آل البيت وتجنيبهم الندم، كما سبق ذكره في متن الكتاب.
وعندما يبدأ التأجّج - كما عرف في علم الطبيعة والفيزياء - فإنّ الحمم تصبّ فوق بعضها، وتحمي ذرّات بعضها البعض، فيزداد اللهب وتتضاعف الحرارة. وكما قيل: فإنّ الإقناع يزداد كلّما كان الشاهد أقرب الى المشهود عليه(2) ، وهذه نقطة مهمّة ودالّة على معجزات شهادة الحسين الروحيّة؛ فقد كشف همجيّة مجزرة الطفّ الجنود العائدون، وأذاعوا تفاصيلها في طول البلاد الإسلاميّة وعرضها، وكان لكلامهم وشهاداتهم أبلغ الأثر في تأجيج نار المشاعر ضدّ الذين فكّروا وقاموا بهذه المجزرة المشينة.
____________________
(1) لـ(سيجموند فرويد) رأي في كتابه (سيكولوجيّة الشذوذ النفسي) / 189 يقول فيه: إنّ يقظة ضمير الإنسان تحيل صاحبها إلى ديّان رهيب لا يخاف لوم ذاته ومعاقبتها بأقصى العقوبات الممكنة.
(2) السيّد المسيح قال:«من فمِك اُدينك» .
مهزلةُ الخروج على الأئمّة
وعلى الرغم من نشاط فرقة (المرجئة) التي أنشأها النظام الاُموي لتغطية نشاطه السياسي، وإسباغ صفات دينية على تصرّفاته، فإنّ الغضبة التي اشتعل أوارها لم تكن لتهدأ إلاّ لتثور مجدّداً وبشكل أعنف.
وقد أعادت ملحمة كربلاء إلى الأذهان ما أفتى به الفقهاء الموظّفون: من أنّه لا يجوز الخروج على الأئمّة، وقتالهم حرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. ففتحت هذه الأذهان على عمليّات التمويه الرسميّة التي موّلها حكّام بني اُميّة لوأدّ كلّ مطالب عادلة، والوقوف أمام كلّ تحريف للسنّة، والسكوت عن مخارف الجَور والانتهاكات.
وفي مقابل تفتّح الأذهان على أضاليل فرقة المرجئة ومؤسّسيها الاُمويّين تفتّحت هذه الأذهان على مبدأ الإمام الشهيد (عليه السّلام) الذي قاله مخاطباً الوليد بن عتبة بن أبي سفيان: «أيّها الأمير، إنّا أهل بيت النبوّة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا يختم. ويزيد رجل فاسق، شارب الخمر، وقاتل النفس المحرّمة، معلن بالفسق، ومثلي لا يُبايع مثله»(1) .
فهذه الكلمات على بساطتها تدلّ دلالة واضحة على جواز نقد الخليفة والثورة على أحكامه والخروج عليه، وتبيّن في الوقت ذاته أساليب المراوغة والتحريف التي
____________________
(1) مثير الأحزان - لابن نما الحلّي.
رفعها الاُمويّون فوق الرؤوس لإيهام الناس وإخافتهم.
وكان لا بدّ للفرد المسلم من المقارنة بين هذا المبدأ الحسيني وذلك المبدأ الاٍُموي، وما كان من نتيجتهما؛ كي يخلص إلى نتيجة واحدة لا مزاحم لها في النهاية ألا وهي: أنّ الحُكم الاُموي حُكم مارق كافر يلعب بالسُنَن، ويسرق الخلافة، ويغتصب البيعة اغتصاباً. فكيف إذا كان على رأس هذا الحُكم خليفة مثل يزيد يجاهر بفسقه، ويتحدّى الله ورسوله، ويزاحم آل بيته على حقّ الخلافة، فذلك معناه موافقة ضمنيّة على فسقه، ومساعدة غير مباشرة على تحدّيه الله.
وعندما يعلن إمامٌ كالحسين (عليه السّلام) منحدر من معدن النبوّة أنّ «يزيد رجل فاسق، شارب الخمر، وقاتل النفس المحرّمة(1) ، معلن بالفسق...». فمعنى ذلك أنّه إفتاء للاُمّة الإسلاميّة بجواز إسقاط هذا الخليفة المزيّف والثورة عليه؛ لأنّ معنى المبايعة هو بيع النفس للخليفة الذي يرمز إلى الشريعة وجوهر الدين، وحامي القرآن الكريم، وولي عهد الرسول المصطفى (صلّى الله عليه وآله) على المسلمين، وفي مبايعته إقرار ضمني بالاستماتة في سبيله عملاً بقوله تعالى:( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ) ، فألزم على المسلم طاعة الخليفة؛ لأنّها تدخل في طاعته عزّ وجلّ.
وعندما يكتشف الإنسان المسلم أنّ بيعه نفسه لخليفة فاحش قد كلّفه التفريط بعقيدته، وبيع نفسه للظلم والفحش الذي يمثّله هذا الخليفة، وبالتالي كسب غضبة الله جرّاء عصيانه، فإنّه يحتقر نفسه، ويزدري قلّة تعقّله حينما بايع خليفةً مزيّفاً، فيتحرّك ضميره ويتفاعل إحساسه بازدراء نفسه ولومها مع مخافة الله
____________________
(1)( ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلاّ بالحقّ ) ، راجع النصّ الكامل للآية 33 من سورة الإسراء.
وعدله، فيثور ويحطّم أصنامه ويموت دون مبدئه راضياً مؤمناً.
وبدءاً من فرضيّة الندم ثمّ مراجعة النفس والوقوف على حقيقتها وحقيقة الاُمور، والظروف التي دوّمتها في دوّامتها، وتبيان الحقيقة الساطعة، مروراً بفترة المراجعة وكمون الأفكار والانفعالات، ونجاحها في تحويل صاحبها من إنسان خامل بلا عقيدة إلى إنسان ديناميكي معبّأ بالمبادئ، فضلاً عن تحرّك الظروف خارج نفس الإنسان وتفاعلها في نواحٍ اُخرى بما يدعم مبدأه الجديد وعقيدته المستيقظة، ممّا يزيد من تصميمه على استمرار الاستسلام لهتافه الداخلي الذي يقوده إلى دروب لم يكن يحلم بالمسير بها، ويفتح أمام بصيرته مغاليق كانت كالسدّ في وجهه، فيندفع بإيحاء من فقدان ثقته بما كان، وانسجاماً مع هتافه الداخلي، ورغبةً منه في تغيير الأوضاع إلى الثورة والتحطيم واقتلاع كلّ زيفٍ من جذوره.
وشهادة الحسين (عليه السّلام) في كربلاء وما تلاها من حوادث السبي نجحت في إيصال الإنسان المسلم إلى بدء رحلة الألف ميل نحو تحرّره وتمكين جذور عقيدته في نفسه بخطوة واحدة، إذ ما كاد ركب السبي يدير ظهره إلى دمشق عائداً إلى الأرض التي تضمّ الجسوم الطاهرة حتّى بدأ الندم يستشري في ضمير اُمّة الإسلام، وبدأت معه عمليّة مراجعة النفس التي ستشكّل محور ما سيأتي بعدها من تغيّرات وانتفاضات تعمّ هذه الاُمّة التي ابتلاها الله بالضعف من بعد قوّة، فيتنادى للتغيير والثورة أقصاها وأدناها(1) .
____________________
(1) شهادة الحسين (عليه السّلام) في كربلاء بحاجة إلى دراسة علميّة ونفسيّة وروحيّة وزمنيّة وافية على أعلى المستويات. إنّ في طوايا هذه الملحمة تكمن اُسس أخلاقيّة لو اُظهرت للبشريّة بشكل علمي مدروس لتغيّرت نظريّات كثيرة، ولأُعطيت أجوبة شافية للعديد من المسائل الروحيّة والزمنيّة، وكيفيّة الربط بينهما.
إنّ نهضة الحسين (عليه السّلام) على الرغم ممّا قدّمته حتّى زمننا هذا لم تزل تطوي في جوهرها كنوزاً من الكيفيّات والدساتير والأساليب والنتائج ذات الصلة الماسّة بمختلف الأصعدة الإنسانيّة بشكل عام، وبالعديد من قضايا الإنسان المعاصر بشكل خاص. فهل تلقى دعوتنا لهذه الدراسة تقبّلاً واقتناعاً؟
معجزاتُ الشهادة الاجتماعيّة
ما أن غادر موكب السبي دمشق حتّى كانت مرحلة الندم والبكاء وقرع الصدور؛ حزناً وتأسّياً وإحساساً بالذنب المتأتّي عن التقصير قد بلغت مداها، وفرّخت مرحلة مراجعة النفس، والوقوف على حقيقتها وحقيقة الاُمور والظروف التي دوّمتها في دوّامتها.
وكان لا بدّ لها من نموذج للأخلاق أسمى؛ إذ من المسلّمات التي تعقب عمليّة اهتزاز القيم والمعايير السائدة أن يبدأ الفرد الذي هو ركن المجموع بالبحث عمّا ينقصه، فتبلبله حيرة لا يعرف معها أيّ شكل من أشكال الاختيار التي تفتّح عليها عقله، وعرضت أمام بصيرته المتيقّظة لتوّها، فيبدأ في البحث عن نموذج أخلاقي يلائم نظرته الجديدة إلى نفسه وإلى الآخرين، وإلى مخارف الدنيا وزخرفها وزهدها ومختلف عناصرها.
وبعد ثورة الحسين (عليه السّلام) مباشرة كان النموذج الأخلاقي للمجتمع الإسلامي هو ذاته الذي كان قبلها، نموذج فيه من المثالب ما لا حصر له، فلم يكن غريباً على المسلمين آنذاك السكوت على البغي، والخضوع للطغي، بل والمشاركة فيه، ولم يكن مستهجناً مبدأ المساومة على المبدأ وبيع النفس، والرضى بخنوع مُذل إذا رافقه
استمرار تدفّق المنافع الدنيويّة، وكان يزيد وحاشيته هم المرآة التي تعكس كلّ هذا للمسلمين، بما يغريهم لأن يكونوا على شاكلتهم ومثالهم سواء أكان ذلك بالترغيب أم بالتّرهيب.
وما كان ممقوتاً مرذولاً في صدر الإسلام؛ من تكالب على المنافع، وحبّ الذات، وإيثار السلامة والدعة، غدا شيئاً مألوفاً، بل ومُطالب به كهدف وغاية يسعى إليها المسلم على قدمَيه، مع علمه بأنّ هذا المطلب الذي قدّسه كغاية بحدّ ذاته يحمل في طيّاته هجر القِيَم الإسلاميّة، والرنو إلى الأخلاق الجاهليّة التي جاءت رسالة محمّد (صلّى الله عليه وآله) فبدّدتها، ووطّدت مكانها قِيَماً سماويّة.
وبعد الهزّة الحسينيّة صار يطيب للفرد المسلم أن يعيد تذكّر مبادئ الحسين التي أعلنها مراراً وتناقلتها الألسن فيما سبق، دون أن تحرّك في الضمائر أيّة إشارة لتقبّلها، حينما كان مدّ الأطماع والغيّ في أقصى حدوده.
أمّا بعد الهزّة فصار لهذه المبادئ وَقْع كوَقْع السحر، تذكّر المسلمون معها مقولة الإمام الشهيد (عليه السّلام) حينما اُحيطت به النوازل وقيل له بالنزول على حُكم بني اُميّة: «لا والله، لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقرّ إقرار العبيد. ألا وإنّ الدعيّ بن الدعي قد ركز بين اثنتين: بين السلّة والذلّة، وهيهات منّا الذلّة! يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجدود طابت وحجور طهرت، واُنوف حميّة ونفوس أبيّة لا تؤثّر طاعة اللئام على مصارع الكرام»(1) .
وفي التذكّر عبرة سيّما إذا كان الدأب هو البحث عن نموذج جديد للأخلاق يلائم المرحلة الجديدة - ما بعد الثورة - فوعى المسلم لأوّل مرّة هذا الخُلق الاجتماعي
____________________
(1) تليها أبيات أنشدها الشهيد لفروة بن مسيك المرادي، ورواها ابن عساكر في تاريخ دمشق 4 / 333.
السليم، وتشرّب معنى الأنفة في الاُنوف، والإباء في النفوس الذي معه يفضّل المَصَارِع على طاعة اللئام.
وبعد أن كان الفرد المسلم يصمت أمام تغيّر الدنيا وتنكّرها وإدبار معروفها، ويرضى بالصبابة كصبابة الإناء التي بقيت منها، ويسرّ بخسيس العيش كالمرعى الوبيل، ويرى الحقّ لا يُعمل به، والباطل لا يُتناهى عنه، فلا يرى في هذه الحياة إلاّ سعادة، والبقاء مع الظالمين إلاّ سلوى.
صار - بعد تفجّر أخلاقيّة الثورة - يرى في كلّ ما كان يرضى به من هذا إنكاراً لدوره كمسلم، وإهداراً لكرامته كإنسان في هذا المجتمع. وما لبث أن صار يردّد مع إمام الثوّار:موتٌ في عزّ خيرٌ من حياة في ذلّ . وصار يحسّ مدى خواره وذهاب نخوته عندما بدأت أخبار المعركة تتناهى إلى علمه فيلُمَّ بتفاصيلها، ليحسّ بعدها برعدة الإحساس بالذنب، ويقدّر مدى تكالبه على الدنيا، ورضاه بالزيف، وبيعه لكرامته التي هي أثمن ما لدى الإنسان بحيث يفقد بفقدانها معنى وجوده.
شعر بالضعة حينما علم بموقف زهير بن القين عندما طالَب الإمام الشهيد صحبه بالانصراف وتركه لمواجهة مصيره وحده، وكيف أجابه: سمعنا يابن رسول الله مقالتك، ولو كانت الدنيا لنا باقية وكنّا فيها مخلّدين لآثرنا النهوض معك على الإقامة فيها.
شعر بالخجل حيال مقولة بدير بن حضير: يابن رسول الله، لقد منّ الله بك علينا أن نقاتل بين يديك؛ تُقطّع فيك أعضاؤنا، ثمّ يكون جدّك شفيعنا يوم القيامة. أحسّ بتخاذله وتواكله حيال قول نافع بن هلال للشهيد: سِر بنا راشداً معافى، مشرّقاً إن شئت أو مغرّباً، فوالله ما أشفقنا من قدر الله، ولا كرهنا لقاء
ربّنا، وإنّا على نيّاتنا وبصائرنا نوالي مَن والاك، ونعادي مَن عاداك.
ما عادت نفس هذا المسلم تملك إلاّ أن تصغر في عين ذاته حينما يقارن بين موقفه وبين موقف زهير بن القين في ميدان الطفّ حيث لا شيء إلاّ الموت: والله لوددت أنّي قُتلت ثمّ نشرت ثمّ قُتلت، حتّى اُقتل كذا ألف قتلة، وأنّ الله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك.
هذا المسلم المدجّن - اُمويّاً - شعر بعدم حفظه غيبة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وآله بالشهيد الحسين، عندما نُميَ إليه ما قاله سعد بن عبد الله الحنفي لسيّد الشهداء: والله لا نخلّيك حتّى يعلم الله أنّا قد حفظنا غيبة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وآله فيك، والله لو علمت أنّي اُقتل ثمّ اُحيا ثمّ اُحرق حيّاً ثمّ اُذرّ - يُفعل ذلك بي سبعين مرّة - ما فارقتك حتّى ألقى حمامي دونك، فكيف لا أفعل ذلك وإنّما هي قتلة واحدة؟!
وحيال مقولة مسلم بن عوسجة أحسّ هذا المسلم بالنقص الغيري، أنحن نخلّي عنك؟! ولما نعذر إلى الله في أداء حقّك؟ أمَا والله لا اُفارقك حتّى أطعن في صدورهم برمحي، وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي، ولو لم يكن معي سلاح اُقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة دونك حتّى أموت معك.
ويتساءل المسلم ما الذي منعه من الوقوف كمثل وقفة بني عقيل لمّا أذن لهم الشهيد بالذهاب والاكتفاء من القتل بمسلم إذ قالوا: فما يقول الناس وما نقول لهم؟ أنّا تركنا شيخنا وسيّدنا وبني عمومتنا خير الأعمام، ولم نرمِ معهم بسهم، ولم نطعن برمح، ولم نضرب بسيف، ولا ندري ما صنعوا. لا والله لا نفعل، ولكن نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا، نقاتل معك حتّى
نرد موردك، فقبّح الله العيش بعدك(1) .
الأخلاقُ معدن الثورات
وأخلاق الثوّار هي المعدن الأصيل في كلّ حركة، ومثل هذه الأخلاق هي التي منعت العبّاس (عليه السّلام) من الشرب حينما تذكّر عطش الحسين ومَن معه، فقذف بالماء وهو يقول:
يا نفسُ من بعدِ الحسينِ هوني |
وبعدهُ لا كُنتِ أن تكوني |
|
هذا الحسينُ واردُالمنونِ |
وتشربينَ باردَ المعينِ |
تالله ما هذا فعالُ ديني(2)
وهي الأخلاق التي دفعت بالحسين الشهيد وهو مطوّق بألف فارس وعلى رأسهم الحر الرياحي، وقد جاؤوا لمناجزته وإقصائه إلى المدينة أو للقدوم به إلى الكوفة؛ كي يأمر أصحابه باسقاء أعدائه وترشيف خيلهم، عبّتين أو ثلاثاً أو أكثر(3) .
هي أخلاق الثوّار التي لا يسمو فوقها أخلاق، والتي دفعت بالشهيد العظيم لأن
____________________
(1) تاريخ الطبري 6 / 238، والكامل 4 / 24، والإرشاد للمفيد، وإعلام الورى / 141، وسِيَر أعلام النبلاء للذهبي / 202.
(2) رياض المصائب / 313.
(3) تاريخ الطبري 6 / 226.
يحني السّقاء بيده ليروي علي بن الطعان ويسقي فرسه، وهو المحارب الذي جاء مع الحر لمقاتلته.
وإذا كان للأخلاق مجاذب مغناطيسيّة قويّة فإنّها تبلغ لدى الثوّار الذين يباركونها بالدم مجاذب أقوى لا يقدر مطلق إنسان على الوقوف حيال قوّة جذبها، وهذا ما دفع بالحرّ الرياحي لأن يترك قيادة الألف فارس وينضمّ إلى جيش الحسين قليل العدد وهو يعلن توبته له، ويطالب بالشهادة دفاعاً عنه وعن مبادئه.
وجذب الأخلاق ما استطاع جون مولى أبي ذرّ الغفاري مقاومته، فتقدّم مستأذناً الحسين للقتال، وهو المولى الأسود الذي ما تبعهم إلاّ طلباً للعافية بينهم، ولمّا رفض الحسين وقع العبد الأسود على قدَمَيه يقبّلهما ويقول: أنا في الرخاء ألحس قصاعكم، وفي الشدّة أخذلكم! إنّ ريحي لنتن وحسبي للئيم، ولوني لأسود، فتنفّس عليّ بالجنّة؛ ليطيب ريحي، ويشرف حسبي، ويبيضّ لوني. لا والله لا اُفارقكم حتّى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم.
فأذن له الحسين (عليه السّلام)، فتقدّم وقاتل، فقتل خمسة وعشرين قبل أن يُقتل(1)
بين مبادئ وأخلاق
فمسلم ما بعد ثورة الحسين (عليه السّلام) غدا صفحة بيضاء مفتوحة تنتظر مَن يخطّ عليها سطراً جديداً، وفي بحثه عن النموذج الأخلاقي لم يكن أمامه مناص من المقارنة بين خُلقَي الحسين ويزيد، وبين تلك المبادئ التي لقّنها أبو كلّ منهما لابنه. وفي مرحلة
____________________
(1) مثير الأحزان - لابن نما / 33، وتاريخ الطبري / 239.
تفهّم الحقيقة التي دوّمته في دوّامتها، صار يسأل ويسمع ويتحدّث ويتذكّر، تذكّر مبادئ الطرفَين من المتقاتلين، وعاود تذكّر مبادئ جيل الآباء الذي سبقهم، وفي غمرة التذكّر وعودة الوعي، تذكّر وصيّة علي (عليه السّلام) لابنه الحسين (عليه السّلام)، في التقوى والأخلاق ومخافة الله والناس فيه، حيث قال له: «يا بُنَي، اُوصيك بتقوى الله (عزّ وجلّ) في الغيب والشهادة، وكلمة الحقّ في الرضى والغضب، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الصديق والعدوّ، والعمل في النشاط والكسل، والرضى عن الله تعالى في الشدّة والرخاء.
يا بُني، ما شرٌّ بعده الجنّة بِشَرٍّ، ولا خيرٌ بعده النار بخير. وكلّ نعيم دون الجنّة محقور، وكلّ بلاء دون النار عافية.
اعلم يا بني، أنّ مَن أبصر عيب نفسه شغل عن غيره، ومَن رضي بقسم الله تعالى لم يحزن على ما فاته، ومَن سلّ سيف البغي قُتل به، ومَن حفر حفرة لأخيه وقع فيها، ومَن هتك حجاب غيره انكشفت عورات بيته، ومَن نسي خطيئته استعظم خطيئة غيره، ومَن كابد الاُمور عطب، ومَن اقتحم البحر غرق، ومَن أعجب برأيه خلّ، ومَن استغنى بعقله زلّ، ومَن تكبّر على الناس ذلّ، ومَن سفه عليهم شُتم، ومَن دخل مداخل السوء اتّهم، ومَن خالط الأنذال حُقّر، ومَن جالس العلماء وُقّر، ومَن مزح استُخفّ به، ومَن اعتزل سَلِم، ومَن ترك الشهوات كان حرّاً، ومَن ترك الحسد كان له المحبّة من الناس.
يا بُني، عزّ المؤمن غناه عن الناس، والقناعة مال لا ينفد، ومَن أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير، ومَن علِم أنّ كلامه من عمله قلّ كلامه.
يا بُني، الطمأنينة قبل الخبرة ضدّ الحزم إعجاب المرء بنفسه، وهو دليل على ضعف عقله. يا بُني، كم من نظرة جلبت حسرة، وكم من كلمة جلبت نقمة.
لا شرف أعلى من الإسلام، ولا كرم أعلى من التقوى، ولا معقل أحرز من الورع، ولا شفيع أنجع من التوبة، ولا مال أذهب للفاقة من الرضى بالقوت. ومَن اقتصر على بلغة الكفاف تعجّل الراحة وتبوّأ حفظ الدعة.
الحرص مفتاح التعب، ومطيّة النَّصَب، وداع إلى التقحّم في الذنوب. والشرّ جامع لمساوئ العيوب. وكفى أدباً لنفسك ما كرهته من غيرك، ومَن تورّط في الاُمور من غير نظر في الصواب فقد تعرّض لمفاجأة النوائب. التدبير قبل العمل يؤمنك الندم. مَن استقبل وجوه العمل والآراء عرف مواقع الخطأ. الصبر جُنّة من الفاقة. في خلاف النفس رشدها.
يا بُني، ربّك للباغين من أحكم الحاكمين، وعالم بضمير المضمرين. بئس الزاد للمعاد العدوان على العباد! في كلّ جرعة شرق، وفي كلّ كلمة غصص. لا تنال نعمة إلاّ بفراق اُخرى. ما أقرب الراحة من التعب، والبؤس من النعيم، والموت من الحياة؛ فطوبى لمَن أخلص لله تعالى علمه وعمله وحبّه وبغضه. الويل الويل لمَن بلي بحرمان وخذلان وعصيان! لا تتمّ مروءة الرجل حتّى لا يبالي أيّ ثوبَيه لبس، ولا أيّ طعاميه أكل»(1) .
هذه الوصيّة التي تضمّنت كل هذه المبادئ الحياتيّة، من خلقية واجتماعيّة ودينيّة، كانت بمثابة الهَدي الذي قاد خطوات الحسين فيما بعد على طرق الحقّ والخير ونصرة المظلوم. وإذا تذكّرها مسلم وطافت فوق مكنونات سويدائه فبماذا ستذكّره؟ وإذا ذكّرته كيف ستكون مقارنته بينها وبين وصيّة معاوية لابنه يزيد حينما حضرته الهلكة فدعاه ليقول له: يا بُني، إنّي كفيتك الرحلة والترحال، ووطّأت لك الأشياء، وذلّلت لك الأعداء، وأخضعت لك أعناق العرب، وجمعت لك من جمع واحد، وإنّي لا
____________________
(1) راجع كتاب الإعجاز والإيجاز - لأبي منصور الثعالبي / 33، وكتاب ينابيع المودّة / 519.
أتخوّف أن ينازعك هذا الأمر الذي استتبّ لك إلاّ أربعة نفر من قريش: الحسين بن علي، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الرحمن بن أبي بكر؛ فأمّا عبد الله بن عمر فرجل قد وقذته العبادة، وإذا لم يبقَ أحد غيره بايعك.
وأمّا الحسين بن علي فإنّ أهل العراق لن يدعوه حتّى يخرجوه، فإن خرج عليك فظفرت به فاصفح عنه فإنّ له رحماً ماسّة وحقّاً عظيماً؛ وأمّا ابن أبي بكر فرجل إن رأى أصحابه صنعوا شيئاً صنع مثلهم، ليس له همّة إلاّ في النساء واللهو؛ وأمّا الذي يجثم لك جثوم الأسد، ويراوغك مراوغة الثعلب فإذا أمكنته فرصة وثب، فذاك ابن الزبير، فإن هو فعلها بك فقدرت عليه فقطّعه إرباً إرباً.
وصيّتان الفرق بينهما شاسع كالفرق بين الظلمة والضياء، فرجل يوصي ابنه بالقناعة وذكر الله، وآخر يوصيه بالطمع والتكالب على الدنيا. ورجل يوصي ابنه باستقبال وجوه العمل والآراء تفادياً للوقوع في الخطأ، وآخر يبلغه بالاسترخاء بعد أن كفاه الرحلة والترحال.
وصيّة رحومة عطوفة أخلاقية تدعو إلى خشية الله تقبّلها شاب من أبيه فغدت له نبراساً ينير طريقه فمشى على هديها حتّى غالبته الحتوف وضيّقت عليه النوازل. ووصيّة مغرورة متراخية تقطر لؤماً ولا أخلاقيّة قدّمها طاغية مريض لابنٍ فاسق ينبئه فيها بصفاقة ما بعدها صفاقة، بأنّه ذلّل له الأعداء، وأخضع له أعناق العرب.
فشتّان بين وصيتَين، إحداهما تنطق بالرحمة، والاُخرى بالظلم، وشتّان بين كلمة علي (عليه السّلام): «ربّك للباغين من أحكم الحاكمين». وبين كلمة معاوية: وذلّلت لك الأعداء، وأخضعت لك أعناق العرب.
شتّان بين مقولة رجل لابنه: «ومَن سلّ سيف البغي قُتل به». وبين قولة آخر لابنه: إن هو فعلها بك فقدرت عليه فقطّعه إرباً إرباً.
هذان الشّتان هما الفارق الذي عناه علي (عليه السّلام) لابنه الحسين حينما ردّد على مسمعه: «ما أقرب الراحة من التعب، والبؤس من النعيم(1) ، والموت من الحياة». فالراحة قريبة من التعب، ولكنّهما على طرفَي نقيض. والبؤس قريب من النعيم، ولكن أين هما من بعضهما. والموت قريب من الحياة، ولكنّ الموت هو النقيض الصارخ للحياة.
إنّها حِكَم إعجازيّة قيلت في كلمات إيجازيّة مكثّفة، وهي لا تخرج على ما أثبته علم النفس من أنّ كلّ أمر قريب من نقيضه لا يفصله عنه إلاّ شعرة، هذه الشعرة هي موقف الشخص من الأمرين الّلذين يوجّهانه، تماماً كموقف شخصَين عرضت أمامهما كأس مملوءة لنصفها ماء، فيرى أحدهما أنّها فارغة حتّى النصف، بينما يراها الآخر ملآنة حتّى النصف. وقد أكّدت نظريّات الفلسفة أنّ العقل البشري يتشرّب المبادئ في فترة الطفولة، ثمّ خلال فترة الكمون التي تعقب فترة الطفولة، ثمّ في فترة الشباب المبكّر.
فالطفولة أشبه بالإسفنجة الماصّة التي تخزن كلّ تجارب ومبادئ الإنسان في عقله الباطن، وتأتي فترة الكمون وهي الفترة التي يعرّفها علم النفس بفترة تناسي كلّ المخزونات في العقل الباطن، فلا تلبث هذه المخزونات أن تعلن عن نفسها بلا حسّ إرادي من صاحبها، وتكوّن مجمل أفكار ومبادئ وتصرّفات الشخص في فترة شبابه وما يليها حيث توضع هذه الأفكار والمبادئ موضع التنفيذ من وحي عقله الباطن، أي من منطقة الغريزة التي لا سلطة للإنسان عليها، والتي لا يمكن له من تفهّم دوافعها وبواعثها، فيتصرّف بإيحاء منها، وكثيراً ما يقف ليسأل نفسه
____________________
(1) في كتابه (العالم كإرادة وتصوّر) يكشف الفيلسوف (أرثر شبنهاور) عن هذا التقارب النفسي والحسّي بين الراحة والتعب، والبؤس والنعيم. في عرضه لعلم الأخلاق القائم على الإنسانيّة الرؤوفة الشفوقة.
بعدها: لِمَ فعلت هذا وذاك من الاُمور؟(1)
والحسين (عليه السّلام) لا يختلف عن غيره في مروره خلال أدوار هذه المرحلة وكذلك يزيد، وقد تشرّبا كلاهما أفكار ومبادئ والديهما واتخذاهما قدوة في مقبل الأيّام، كذلك كان للبيئة أثرها في تكوين نفسيّتيهما، فمضى الحسين (عليه السّلام) في كلّ مراحل حياته يعمل بوحي من بيئته الأدبيّة الإسلاميّة التي رضع أخلاقيّاتها مع حليب طفولته، فلم يسمع أيّ إنسان عن الحسين طيلة حياته كلمة، أو يعاين له موقفاً يدلّ على عكس السمّو والنبل والأخلاق والحرص على الدِّين.
وفي المقابل لم يسمع أيّ إنسان عن يزيد طيلة حياته كلمة، أو يعاين له موقفاً يدلّ على عكس الخسّة والعبث والظّلم والحرص على الدنيا.
وفي ميزان المقارنة الذي نصبه الإنسان المسلم بعد ثورة الحسين (عليه السّلام) وضع في كفّتَيه كلّ ما يتّصل بشخصي الحسين ويزيد، ثمّ ابتعد قليلاً وألقى نظرة فاحصة مقارنة حياديّة تبغي الحقّ الذي أخذ يلحّ في ضميره.
رأى في كفّة الحسين شمائل النبوّة ومواقف الرجال الأفذاذ، وسمع من جانبها مبادئ الحقّ والعدل، ورأى في كفته (عليه السّلام) ميراثاً فكريّاً محمّدياً، لا قبليّاً ولا إقليميّاً، خال من التعصّب إلاّ فيما يتعلّق منه في مسائل العقيدة، ورأى في كفّته سرّ النبوّة، سرّ الجدّ والسّبط في آنٍ معاً، وتخيّل الرسول يقبّل سبطه في شفتَيه ويردّد: «حسين منّي وأنا من حسين».
____________________
(1) وهذا ما يسمّى في علم النفس بـ(الأفعال اللاإراديّة).
ثمّ رأى هذا الطفل رجلاً يرفع راية الإسلام فوق رأسه، وتخيّله يعلن بملء فيه: «مَن قَبِلني بقبول الحقّ فالله أولى بالحقّ».
ورآه متخيّلاً يبتعد عن مجلس أبيه علي (عليه السّلام) ونفسه مترعة بقولة أبيه التي كان يسرّها في أذنه كوصيّة: «مَن تكبّر على الناس ذلّ». ثمّ رآه في مكان آخر يقول لبعض الناس: «أنا الحسين بن علي، وابن فاطمة بنت رسول الله، نفسي مع أنفسكم، وأهلي مع أهليكم، فلكم فيّ أسوة». رآه في مواقع العمل في المبدأ، فأعجب كيف عمل به بهذه الأمانة، ووضع نفسه اُسوة مع غيره. رآه كأسد جائع إلى إحقاق الحقّ، وقد قرّر الزحف باُسرته الصغيرة، قليلة العدد والعدّة في وجه كثرة العدو، وخذلان الناصر، وسمعه يردّد:
فإنْ نُهزَم فهزّامون قدماً |
وإنْ نُغلَب فغيرُ مغلّبينا |
|
وما إن طبّنا جبنٌولكنْ |
منايانا ودولة آخرينا |
|
إذا ما الموتُ رُفّع عن اُناسٍ |
كلاكلَهُ أناخ بآخرينا |
|
فأفنى ذلكمْ سرواتِ قومي |
كما أفنى القرونَ الغابرينا |
|
فلو خَلُدَ الملوكُ إذاًخلدنا |
ولو بقي الكرامُ إذاً بقينا |
فقُل للشامتينَ بنا أفيقوا |
سيلقى الشامتونَ كما لقينا(1) |
ورأى في كفّة الشهيد كيف تحرّك في وجه معاوية حينما كان يعدّ ابنه للخلافة، وتخيّله جالساً فوق الرمال جلسة متواضعة زاهدة وهو يخطّ رسالة لمعاوية يطالبه فيها بأخذ يزيد فيما أخذ فيه من استقرائه الكلاب المهارشة عند التهارش، والحمام السبق لأترابهن، والقيان ذوات المعازف، وضرب الملاهي وترك ما يحاول من إيهام الناس فيه، كمَن يقدح باطلاً في جَور وحنقاً في ظلم.
رآه يرفض البيعة ليزيد بكلمته الشهيرة: «ومثلي لا يبايع مثله». ورآه يتمرّد على طاعة إمام مزيّف. رآه وهو يخرج من المدينة إلى الكوفة، ورأى مواقفه الشجاعة في مواقع الخطر، وسمع أقواله وكلماته الأخيرة أمام أشداق الموت، فلم يجد فيها أدنى اختلاف عن تلك التي عرفها منه وهو آمن مطمئن في المدينة بعيداً عن منازل حتفه.
ثمّ رآه فوق ثرى الطفِّ رابط الجأش قويّاً، يشعّ وجهه بنور سماوي بينما يتساقط حوله خلّص صحبه وأهل بيته، وتنتهك حرمه على مرأى منه.
رآه يقف كالأسد الهصور وحيداً يصيح في وجه أعداء الدِّين يدعوهم للبراز وهو يردّد:
____________________
(1) اختلفت المصادر في نسبة هذه الأبيات، فنسبها ابن هشام في السيرة لغروة بن مسيك المرادي، ونسبها الفرزدق إلى خاله العلاء بن قرظة. أمّا المرتضى في الأمالي فقد نسبها إلى ذي الإصبع العدواني، وفي عيون الأخبار لابن قتيبة، وفي شرح الحماسة للتبريزي أنّها للفرزدق.
أنا الحسينُ بنُ علي |
آليتُ ألاّ أنثني |
|
أحمي عيالاتِ أبي |
أمضي على دينِ النبي(1) |
ورآه وهو يقبّل ولده الرضيع ويودّعه قبل أن يلقى حمامه، ثمّ وهو يرفعه فوق يديه على مرأى من وحوش بشريّة تحجّرت قلوبها، ورأى حرملة بن كاهل الأسدي يرمي الرضيع بسهم فيذبحه وهو بين يدي أبيه.
رآه، ورآه، ورآه، في كلّ موقف وفي كلّ ميدان، رآه كما يرى الإنسان البرق فلا يلحقه ببصره، رآه في الميدان ممدّداً وشمر بن ذي الجوشن الكلب الأبقع ينيخ على صدره ويقبض على شيبته المقدّسة ويضربه بالسيف اثنتَي عشرة ضربة، ثمّ يحتزّ رأسه الشريف.
وتتوالى المشاهد بعد ذلك أمام ناظري المسلم، منبعثة من كفّة الحسين (عليه السّلام)، فيرى رأسه فوق رمح، ويرى موكب السبي الذي يفتّت القلوب، ويعبر في مجاز خياله منظر الرأس الشريف في طبق عند أقدام طاغية، وقضيب ينكت شفتَيه. ومع ما كان يراه، كان يسمع صوت العقيلة زينب يذكّره ببيعة نفسه لشيطان أطماعه الدنيويّة ليشتري بثمنها مكاناً مقيماً في الجحيم.
وحينما يصل هذا المسلم إلى هذا الحدّ من الرؤى المنبعثة من كفّة الشهيد (عليه السّلام)، ينفطر قلبه توجّعاً وتدمع عيناه ندماً، فيقرع صدره ويضرب خدّيه، وما يلبث أن يلتفت نحو الكفّة الثانية، فماذا يرى؟
____________________
(1) مناقب ابن شهر آشوب 2 / 223.
في كفّة يزيد
يرى يزيد جالساً بين ندمائه يعاقر الخمرة، ويعابث النساء، وأمامه كلاب مسرجة بحللٍ من ذهب، وبعض الجواري ممَّن تحلّين باللآلئ يرحن ويغدون بصوان من ذهب خالص. وأمام يزيد صينيّة ملأى باللؤلؤ الناصع، وعند رجلَيه شاعر معروق يقول فيه قصيدة ركيكة المعنى والمبنى، وهو منصرف عنه يقهقه بصوت ماجن، وأصابعه المحشوّة بالخواتم تعبث بصدر جارية رومية. وينتهي الشاعر من قصيدته فيتنبه يزيد لذلك، فيعتدل لينشد بدوره:
أقولُ لصحبٍ ضمّت الكأسُ شملَهمْ |
وداعي صباباتِ الهوى يترنّمُ |
|
خذوا بنصيبٍ من نعيمٍولَذةٍ |
فكلّ وإن طال المدى يتصرّم (1) |
وهو في مجلس شرابه وندمه، إذ بأحد الخدم يقتحم عليه قصفه ويسرّ باُذنه ببضع كلمات يتغيّر على أثرها لون وجهه، ويهبّ لا مبالي، وقبل أن يغادر يطلب من وكيل جلسته أن يحشو فم الشاعر المعروق لؤلؤاً تكريماً له، ثمّ يختفي عن الأنظار ليظهر أمام أبيه المحتضر.
____________________
(1) راجع حياة الحيوان - الدميري 2 / 270.
وفي صمت يتقبّل منه وصيّته الأخيرة لينطلق بعدها في عمليّات لا حدّ لها من التهوّر، مخالفاً بذلك وصيّة والده في بعض فقراتها.
رأى المسلم يزيد خلال ثلاث سنين ونصف قاتلاً مفضحاً، بدأ ولايته بقتل الحسين، وفي سنته الثانية أباح المدينة ثلاثة أيّام بعد أن نهبها، وقتل فيها سبعمئة من المهاجرين والأنصار، وعشرة آلاف من الموالي والعرب والتابعين، وافتضّ ألف عذراء(1) .
رآه يداعب قرده (أبا قيس) ويلبسه الحرير ويطرّزه بالذهب واللآلئ ويركبه أتاناً في السباق ويجهد كي يجعله سبّاقاً على الجياد، ويقول فيه:
تمسّك أبا قيسٍ بفضلِ عنانِها |
فليس عليها إنْ سقطتَ ضمانُ |
|
ألا مَن رأى القردَ الذي سبقت بهِ |
جيادَ أمير المؤمنينأتان ُ(2) |
ورآه متثاقلاً متمارضاً، بينما جيش أبيه يتّجه إلى القسطنطينيّة، وسمعه حينما ضرب الجوع والمرض هذا الجيش في منتصف الطريق، ينشد هذه الأبيات التي تدلّ على ختله وخداعه:
ما إنْ اُبالي بما لاقتْ جموعُهُمُ |
بـ (الفرقدونة) من حمّى ومن مومِ |
____________________
(1) الذهبي في سير أعلام النبلاء، ورسالة الجاحظ / 298 الرسالة الحادية عشرة في بني اُميّة، عن المقتل المقرّم.
(2) أمالي الزجاجي / 45.
إذا اتّكأت على الأنماطِ مرتفقاً |
بدَير مرّان عندي اُمّ كلثومِ(1) |
ورأى معاوية حينما بلغه هذان البيتان يقسم ليلحقنّ ابنه أمير المؤمنين المزمع بالجيش تفادياً للفضيحة ودرءاً لشماتة المسلمين، بعد شيوع هذا القول في مختلف الأوساط.
ورأى يزيد يطلب من ابن زياد بثّ عيونه خلف الحسين خلال توجّهه إلى العراق، وحبس الناس على الظنّة وقتلهم على التّهمة. ورآه في حضن اُمّه ميسون بنت عبد الرحمن بن بجدل الكلبي، بعد أن ولدته بالحرام من عبدٍ لأبيها مكّنته من نفسها فحملت به.
ورآه على شاكلة جدّه أبي سفيان عدوّ الله والإسلام الذي قاد الحرب ضدّ القرآن في بدر واُحد والأحزاب. ورآه على شاكلة جدّته هند المغرمة بحبّ السود، والتي أنجبت والده معاوية بعد زواجها من جدّه بثلاثة أشهر، والتي أكلت كبد حمزة عمّ الرسول، ولقّبت بآكلة الأكباد.
رآه على شاكلة أبيه معاوية الذي حارب علياً في صفين، وقتل عمّار بن ياسر، وسمّ الحسن، ومالك الأشتر، وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد. رآه ينشد (ليت أشياخي ببدر شهدوا) حينما رأى رأس الحسين على سنّ رمح، وسمع قهقهته وهو ينكث ثنايا الرأس الشريف بالقضيب.
____________________
(12) الكامل لابن الأثير 3 / 197.
رآه يشرف من قصره على موكب السبي المشدود بالحبال على أقتاب الجمال، ورأى الإمام زين العابدين وفي عنقه الأغلال، ورأى رؤوس شهداء الطفّ فوق أسنّة الرماح.
رآه يأمر فيتحوّل أمره إلى إبادة لذريّة الرسول، ويأمر فيحتزّ رأس ريحانة الرسول، ويأمر فيوطأ جثمانه الطاهر بحوافر الخيل. رأى، ورأى، ورأى، حتّى كادت المشاهد تختلط ببعضها مع ما فاض في مآقيه من دمع، وبين كفّتي الحسين ويزيد أخذ بصره يتابع بحدّة وسرعة كثافة الرؤى والأحداث، فغدت هذه الرؤى كشريط ذكرى وتذكّر يُعرض أمام ناظريه بما لا يجعله يقف طويلاً عندها بعد أن بلغت روحه التراقي، ولم يعد بإمكان مشاعره المثلومة أن تركّز على ما يعرض أمامه، وما يراه بصره خلال تنقّله بين كفّتي الخصمين.
رأى الحسين، ورأى يزيد، ورأى معاوية، ورأى علياً، ورأى زينب، وها هو الشريط يتسارع أمام عينيه، وها هو الحسين طفلاً بين يدي جدّه، وجدّه يقول: «اللّهمّ أحبّه فإنّي اُحبّه». علي يقول لابنه الحسين: «مَن سلّ سيف البغي قُتل به».
يزيد يرقّص القرد كقرّاد، والحسين يهتف: «قوموا رحمكم الله إلى الموت الذي لا بدّ منه». ويزيد يهتف:أسقني شربة تروي مشاشي. ومعاوية يأخذ البيعة بحدّ السيف.
زينب تصرخ: يا جدّاه، يا رسول الله! أنا ناعية إليك ولدك أخي الحسين.
يزيد بين القيان والجواري، ويزيد بين نساطرة الشام. الحسين يَهَب مال بيته للفقراء، ويزيد يحشو فم شاعرٍ باللؤلؤ.
علي: «ليس مَن طلب الحقّ فأخطأه كمَن طلب الباطل فأدركه».
زينب تهتف بوجه يزيد: فوالله ما فريت إلاّ جلدك ولا حززت إلاّ لحمك.
يزيد يقول لعلي بن الحسين: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم.
معاوية يدسّ السمّ لخصومه السياسيّين.
الحسين مقطوع الرأس في كربلاء.
يزيد يأمر بمنع الماء عن الحسين.
يزيد يشير إلى الرأس الشريف ويسأل: أتدرون من أين أتي هذا؟
الحسين بين اُمّه فاطمة الزهراء وأبيه علي. ويزيد بين اُمّه ميسون وأبيه معاوية.
معاوية يحتضر ويكذب بأنّ الرسول (صلّى الله عليه وآله) كساه قميصاً وقلّم أظفاره يوماً.
الحسين يهتف: «ألا من ناصرٍ... ألا من معينٍ...».
الحسين يستعطف قوماً غلظت قلوبهم لجرعة ماء لرضيع.
معاوية في غبش الرؤيا، خفيّ المعالم، غامض المبادئ والمواقف.
الحسين المقتول سبط الرسول الكريم.
يزيد القاتل ابن معاوية الثعلب.
علي جامع الفضائل وحامل راية الإسلام من يد النبي.
معاوية يغتصب الخلافة لابنه عنوةً.
آل البيت أحقّ بالخلافة من بني اُميّة.
يزيد شارب الخمر معلن بالفسق.
الحسين سيّد شباب أهل الجنّة، وطالب الإصلاح في اُمّة جدّه.
يزيد جعل الخلافة الإسلاميّة بيد السفهاء والقيان والفهّادين والغلمان. والحسين استشهد مع عترة النبي دفاعاً عن عقيدة الإسلام.
* * *
وفي مثل هذه المواقف التي وجد المسلم بها نفسه، تعصف به رياح الشكّ والندم فيما كان وقف متأمّلاً على مفترق عدّة طرق، وقف بعد أن أجّجت ضميره عصفة غثر عصفة من عواصف المُثل الثوريّة الجديدة، فدفعته إلى التساؤل بينه وبين نفسه، وكان يسمع إجابات داخليّة تربّت حيناً، وتدغدغ حيناً آخر، وتدقّ مراراً.
وقف يسأل على مفترق طرق قبل أن يقرّر سلوك إحداها ليصل إلى ما يعزم عليه، وإلى الهدف الذي يتبدّى له أصلح من غيره نتيجة ما يتجمّع في قناعاته، وما يتولّد من أفكاره ومبادئه، وما تفرزه الأحداث والخضّات التي أصابته في الصميم.
سأل نفسه: مَن أنا؟ أجابته نفسه:
أنت مسلم ما بعد الثورة.
وما كُنته قَبْلَها إذاً؟
لم تكن شيئاً، فقد بعتني للشيطان وقبضت الثمن.
كيف؟
رأيت الباطل فسكتّ عنه.
لم أكن أعرف أنّه باطل.
بل عرفت، ورأيت الحقّ يُداس فلم ترفع إصبعاً.
لم ألحظ هذا الأمر.
بلى، لحظته وتعامَيت.
لم يصل إلى مسمعي.
بلى، وصل وتصاممت.
ما كان عليّ أن أفعل؟
أن تهبّ وتقتلع.
اقتلع ماذا؟
الزيف، الظلم، الضنك وانتهاك العقيدة.
ومن أين لي القدرة وأنا الضعيف؟
لست ضعيفاً، بل قويّاً، تعاميك وصممك قوة.
وهل أقدر على الطغاة؟
أجل، بنصرتك رافعي لواء الحق.
ومَن هم هؤلاء؟
الحسين.
وأين كنتُ سألقاه لأنصره؟
في قلبك وداخل مأوى عقيدتك
لو أدركته لنصرته.
ما دمت سكتّ عن يزيد فلن تنصر حسيناً.
وهل نُصرتي كانت ستفيده؟
عندما تنصره تضيف لسيوفه سيفاً جديداً
لا أكذّب، فلم أعِ ذلك في حينه.
ألم أقل لك بأنّك تعاميت وتصاممت. فلم تعد ترى ولا تسمع؟
ولكنّي مسلم. وطاعة الخليفة واجب عليَّ.
الخليفة الذي قتل سبط النبي باسم إسلام جدّه؟
لقد اشتريت دنياك بآخرتك.
أنا نادم بعد أن علمتُ بما جرى.
وما يفيد ندمك الآن أيّها المسلم؟
ألا يفيد بشيء؟ ألا يمكنني فعل شيء؟
بلى، يمكنك مقايضة دنياك بآخرتك.
أنا مستعدّ لهذه المقايضة. علّ أن يرتاح ضميري.
إذاً فهل تُقِرّ بأنّك لم تنصر الحسين؟
اُقِرّ.
وبأنّك نصرت يزيد بسكوتك على مخازيه؟
اُقِرّ.
وهل لديك فكرة عن كيفيّة إراحة ضميرك.
بأن أنصر الحسين واُناجز يزيد.
ولكن الحسين قُتل ولم يبقَ إلاّ مبادئه وشعارات ثورته.
سأسير إذاً على هذه المبادئ منذ الآن فصاعداً.
وهل بمَكنَتِك وأنت خارج للتوّ من معمعة تخاذلك؟
يا نفسي ارحميني، كنتُ ضالاًّ فاهتديتُ، وكنتُ طمّاعاً فشفيت.
لثورة الحسين شعارات لا يحتملها إلاّ المؤمن.
أنا مؤمن، أنا مؤمن.
وكيف ستبرهن على إيمانك؟
بكَوني مسلماً، وبعملي بمبادئ الحسين منذ التوّ.
لا يكفي هذا، فقد كنت مسلماً حينما خذلت الحسين.
يا نفسي، رحماك، أشيري بما يتوجّب عليَّ فعله وسأفعله.
أولاً: أن تلزم نفسك بكلّ كلمة نطق بها سيّد الشهداء.
سأفعل، سأفعل.
وأن تعمل بكلّ مبادئه مهما لحقك من أذى.
لم تعد تهمّني حياتي، بل راحة ضميري كمسلم.
وأن تبدأ منذ الآن بهدم أصنام مجتمعك وأخلاقك.
سأهدمها، واُفتّتها.
وأن تنصر الحسين.
تقصدين مبادئه التي أعلنها؟
أجل، وقصدي أن ترعى بنفسك ما زرعه في داخلك، وتُتمّم ما بدأه فيك.
هلاّ أخبرتِني بما زرعه لأكون على بيّنة؟
زرع فيك حبّ الخير، وعشق الحقّ، وسلامة العقيدة، والثورة على الظلم، والتصدّي لمحرّفيّ السنن، وزارعي الفتنة، ومحقّري الرسالات السماويّة.
يا ويلي، يا ويلي من لقاء وجه ربّي! كلّ هذا كان ونحن عنه
غافلون؟
أجل، ولهذا ثار الحسين، ولهذا قُتل مع ذريّة الرسول.
كفى يا نفسي، كفى، أكاد أذوب حسرة.
وأنت ساكت عن كلّ ذلك.
آه، إنّي حزين ونادم، ليتني أفقت قبل ذلك، كنت نائما مخدّراً قبل أن رأيت رأس سبط الرسول على سنّ رمح كرأس قاطع طريق أو مجرم.
أتعرف مَن فعل ذلك؟
أعرف، أعرف، يا ويلك يا يزيد من انتقامي!
لقد قُتل ابن فاطمة الزهراء وابن علي وحفيد محمّد وشقيق زينب ووالد سكينة والسجّاد. هؤلاء أخيار الله من عترة نبيّك الذي هداك إلى رسالته.
سحقاً لك يا يزيد وسحقاً لي ولكلّ مَن سكت عنك! ولكن صبراً، فلن تفلت من انتقامنا.
لو قلت هذا مع حسين لما تحمّلت وزر دمه الطاهر.
ليتني قلته معه.
كنت خنوعاً وقتها، ذليلاً، مساوماً على إنسانيّتك لشيطان أطماعك، مؤثّراً السلامة على سلامة دينك، فقبحاً لك!
* صوت بكاء ونشيج ولطم على الخدود.
عشرون عاماً بعد مقتل أمير المؤمنين علي، وأنت صامت حيال التّقتيل والظلم وسرقة الأموال واستباحة الأعراض، وتحريف السنّة.
* صوت البكاء يعلو ويزداد لطم الخدود
كنت مغرماً بعشق ذاتك حتّى بَلا الله خيارك، فوجدت نفسك كاذباً في موطن ابن بنت نبيّك، فبخلت عنه بنفسك حتّى قُتل أمام عينَيك، وأنت لا تمدّ لنصرته يداً، ولا تجادل عنه بلسانك، ولا تقوّيه بمالك، فما عذرك عند ربّك ساعة لقاء نبيّك؟
* عويل وصراخ كصراخ الذبيح وقرع على الصدور.
لقد وَنيتَ، وتربّصت، وانتظرت حتّى قُتل فيك ولد نبيّك وسلالته وبضعة لحمه ودمه، وريحانته، وسيّد شباب أهل الجنّة، فحقّ عليك سخط ربّك.
كفى يا نفسي، فأنا راغب في الموت تكفيراً عن إثمي، فأرشديني.
لا عذر لك أمام نبيّك يوم القيامة، إلاّ عندما تقتل قاتلي ابن نبيّك، فلا ترجع إلى أهلك وأطماعك الدنيويّة حتّى ترضي الله ونبيّه بالانتقام من قاتلي شهيد كربلاء.
لن يهدأ ضميري حتّى أقضي بما تَشْرِين.
إذاً هيّا أصلح مجتمعك وأخلاقك وطهّرهما.
وهل سأكون وحدي؟
عندما تخطو وحدك ستلتقي خطواتك بخطوات مسلم آخر على الدرب.
وإلى أين يقودنا الدرب؟
إلى عرش يزيد، وإلى صرح كلّ طاغية وظالم
وإذا سقط يزيد. هل يصلح الإسلام.
ثورة الحسين لم تقم لإسقاط عرش يزيد. بل لدكّ عروش البغي في كلّ زمان ومكان.
لم أفقه شيئاً.
ستفقه كلّ ذلك بعد أن تؤدّي ضريبة دينك وعقيدتك. وتكفّر عن إثمك، وتبرهن عن ندمك بخذلانك الحقّ والسكوت عن الباطل، عندها ستفتّح بصيرتك وتفهم كلّ شيء.
ومبادئ ابن النبي الأكرم لن تستعصي على ضميري اللهوف إلى تشرّبها؟
أجل، لن تستعصي بعد أن تفعل ما أمرتك به.
وهذا المفترق، بأيّ طريق أسلك منه لأصل إلى خلاص نفسي؟.
اسلك هذا الطريق الذي قلّ السالكون به؛ لأنّه طريق الحقّ الذي عناه أمير المؤمنين علي.
وهذا الطريق سيمكّنني من إراحة ضميري والتكفير عن تقصيري وإعادتي إلى حظيرة نبيّي محمّد، والانتقام من قاتلي سبطه وذريّة بيته؟
أجل، وسيستردّني من الشيطان الذي بعتني له.... أنا نفسك.
وما اسم هذا الطريق؟
طريق الحسين.
معجزات الشهادة الزمنية
فيا لك حسرةً ما دمتُ حيّاً |
تَردّد بين حلقي والتراقي |
|
فلو فلق التلهف قلبَ حيٍّ |
لهمّ اليوم قلبي بانفلاقِ |
|
فقد فاز الاُلى نصروا حسيناً |
وخاب الآخرون إلى النفاق(1) |
هكذا كان يقول لسان حال مسلم ما بعد الثورة، فهو بعد خذلانه لبطل الطفّ صار يحسّ نقيصة تفري ضعفه الباطني، جعلته يتفرّس طويلاً في خيالات اُولئك الأشاوس الذين قضوا فوق ثرى كربلاء دون الحقّ الذي رفع رايته أسد الحقّ وسار بها إلى حيث المصارع والحمام وهو عالِم بما ستؤول إليه حركته.
____________________
(1) أبيات قالها عبيد الله بن الحر الجعفي ندماً على قعوده عن نصرة الحسين (عليه السّلام).
وحركة الحسين (عليه السّلام) كان لها هدفان لا ثالث لهما:
الأول: إحداث رجّة عنيفة في كيان الاُمّة الإسلاميّة، وهذا هدف مبدئي وليس مرحلي أو نهائي.
الثاني: وضع الاُسس النهائيّة والمبادئ الضروريّة لحفظ كيان العقيدة إلى الأبد، محاذراً بها أن تزل أو تضعف أو تضمحل على يد أفراد أو سلاطين، وهذا هو هدفها الجوهري والرئيس والأساسي.
وليس في سدى الحركة أو لحمتها ما ينبئ عن هدفٍ ثالث، وكلّ الذين وضعوا لهذه الحركة هدفاً ثالثاً إنّما كانوا يرتدّون بها من حيث لا يدرون، ويقصدون إلى مسار آني مرحلي لا يملك من مبرّرات وجوده إلاّ الوقت الزائل بزوال أسبابه.
فما ذهب إليه إذاً مؤرّخو الحركة من إسناد هدف إسقاط عرش يزيد أو حكم بني اُميّة لثورة الحسين كهدف بحدّ ذاته قامت الثورة لأجله، كان في معظمه إسناد لا يتكّئ على الحقيقة الجوهريّة للثورة.
فسقوط عرش يزيد كان واحدة من معجزات الثورة الزمنيّة أي تلك المتعلّقة بأشكال الحكم القائمة، أو بالأفراد الذين يسوسون الاُمّة في تلك المرحلة، وإذا كان لهذه المعجزة من سبب وهدف فليس إلاّ لأنّها متمّمة للمعجزتين (الروحيّة والاجتماعيّة) اللتَين كانتا الهدف الأسمى لثورة الشهيد.
وبتحديد أدقّ كانت المعجزة على مستوى ضمير اُمّة الإسلام هي الهدف الأوحد لثورة الحسين الذي به قوّمت الاُمّة وعقيدتها، والتي شكّلت أساس كلّ المعجزات الاُخرى التي لا بدّ وأن تتحقّق من أجل استكمال صورة المعجزة الروحيّة بتمامها، فتصبح لها سنداً وعضداً وعاملاً مكمّلاً.
فإذا نظرنا إلى ما ذهب إليه البعض في إسناد هدف إسقاط عرش يزيد بالذات إلى حركة الحسين، وإذا قمنا بدراسة متعمّقة لأفكار ومبادئ ومواقف هذه الثورة
منذ انبعاثها شرارة صغيرة حتّى اكتمالها حريقاً هائلاً يأكل هيكل الاُمّة الإسلاميّة المنخور ليشيّد على أنقاضه هيكلاً سليماً، لَما وجدنا أيّة إشارة لكون الحركة تضع مشكلة إسقاط عرش يزيد كهدف، سواء كمرحلي أو مبدئي أو نهائي ضمن أهدافها.
فالثورة لم تكن ثورة لفرديّة مجتمع أو لشريعة حكم، بل كانت ثورة الإنسان وشرائع الفطرة الدينيّة السليمة، ما دام الإنسان هو المستفيد منها، فلا يحيد عن سنّته مهما تبدّلت وتنوّعت شرائع الحكم والمجتمعات، وله في هذا الناموس مرشداً:( فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ) (1) .
إنّ الرمز العميق في ثورة الحسين لآية تنحت في الفطرة الإلهيّة الأزليّة التي لا زمان ومكان وأحكام تقيّدها، فإذا كانت ثمّة من تبدّل أو إكمال لهذا الرمز في بعض مواقع وظروف، فليس معنى ذلك صيرورته رمزاً ظرفيّاً أو زمنيّاً صرفاً، بل إنّ الظرفيّة والزمنيّة تنجرفان أمامه أو تلتصقان به بحكم مروره فيهما أو فوقهما.
وعندما جاءت هذه الثورة لم تطلب من الإنسان أن يأخذ بجزئيّاتها وتفاصيلها، بل دعته للنظر إليها بمنظور شمولي، وأن يقف بعيداً عنها مسافة كافية ليتبيّنها جيّداً، فهي شكّلت الإطار والصورة معاً، ومن الإغماط لها كثورة قدسيّة أن ننظر إليها كصورة فحسب أو كإطار وحده.
فلو نظرنا إليها بهذه السطحيّة لكنّا كمَن يخضب الفطرة الإلهيّة بالصنعة البشريّة، ولوجب علينا أن ننظر على مقياسها إلى موقعة كربلاء، نظرة مادّية صرفة
____________________
(1) سورة الروم / 30.
تقودنا إلى اعتبارها موقعة عسكريّة ليست إلاّ.
فهي في شكلها المادّي الصرف موقعة عسكريّة صرفة، هزمت فيها الكثرةُ القلّة، وفي مضمونها لا تحتوي على أدنى شَبه بالمعارك العسكريّة.
وكرمز روحي، وكعبرة زمنيّة موحى بها من السرّ الإلهيّ كانت معركة كربلاء من جانب الحسين رمزاً لوقفة الحقّ على ضعف وسائله لا لحمته، ومن جانب يزيد كانت رمزاً لجَولة الباطل الذي يفوز بوسائله على بطلانها.
فمن هذه النقطة بالذات يتاح لنا النظر إلى إكمال المعجزة الروحيّة الأساسيّة للثورة بمعجزة زمنيّة، تتجلّى في سقوط عرش يزيد بواسطة ذلك الحقّ ضعيف الوسائل، ذاته الذي كانت له الغلبة عليه في كربلاء بأنّها عكس لدورة الحقّ والباطل، وتبيان للقوّة الحقيقيّة لكلّ منهما. وفي هذا سرّ فوق بشري تقدّمه العناية الإلهيّة لمَن شكّكت نفوسهم، وتهاوت عزائمهم أمام نجاح جولة الباطل، كما حدث للضحّاك بن عبد الله المشرقي الذي لازَمَ الحسين منذ بدء ثورته، ولمّا لَم يبقَ فوق أرض المعركة إلاّ اثنان كان هو ثالثهما. استأذن الحسين بالذهاب تاركاً إيّاه أمام قوّة الباطل، نافذاً بجلده مستشعراً ضعف وسائل الحقّ التي يحارب بها.
وفي موقف الضحّاك عكس لموقف الحرّ بن يزيد الرياحي، الذي انضمّ إلى الحسين عن وعيٍ تامّ بغلبة الباطل على الحقّ، فترك صفّ الباطل المنتصر، وانضمّ إلى صفّ الحقّ المتهيّئ للهزيمة.
وفي مقولة الرسول الأعظم: «أنا وأهل بيتي شجرة في الجنّة وأغصانها في الدنيا، فمَن تمسّك بنا اتّخذ إلى ربّه سبيلاً»، دلالة كافية على حتميّة التمسّك بالشريعة التي هي سبيل إلى الربّ، لا لغاية زمنيّة اُخرى.
إلاّ أنّ معجزة الشهادة الزمنيّة فرضتها حتميّة الشهادة بذاتها، فالحسين عندما ثار
لم يقل: إنّي خرجت لإسقاط يزيد أو دكّ عروش بني اُميّة، بل قال: «وإنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً، ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في اُمّة جدّي».
خرج لطلب الإصلاح في اُمّة محمّد، ولإحقاق الحقّ في المجتمع الإسلامي(1) ، ولرفع الظلم والضنك عن كاهل الفرد المسلم، ولإحلال مناقبيّة أخلاقيّة جديدة تحلّ محلّ تلك المناقبيّة المدجّنة التي ربضت في النفوس، ولذبّ أذى المنتهكين عن العقيدة الوليدة، كان هذا هدفه، وكان ضمير الاُمّة مرمى كرته.
لم يكن عرش يزيد إذاً كهدف بحدّ ذاته سعى الحسين بثورته إليه، بل كان هدفاً مكمّلاً لهدفٍ أسمى لا دخل له بالعروش الزمنيّة بقدر ما كان دخله بأنماط الحُكم في كلّ زمان ومكان، وبأنماط الشخصيّة الإسلاميّة، وبأساليب أخذها للسنّة والعمل بها، كما لم تكن موقعة كربلاء معركة عسكريّة انتهت في العاشر من محرّم بانتصار وانكسار، بل كانت رمزاً لموقف أسمى لا دخل له بالصراع بين القوّة والضعف، بين العضلات والرماح، بقدر ما كان ذا صلة بالصراع الحقيقي بين قوّة وضعف النفوس، بين الشكّ والإيمان، بين المسلم وعوامل إبعاده عن عقيدته.
وهو رمز يصلح لكلّ موطن وجِدَ فيه حاكم ظالم، ولكلّ زمن اهتزّت فيه العقيدة، ولعلّ أفضل ما يصوّر كون هذا الرمز ناموساً لكلّ العصور والأكوان هذا البيت من الشعر:
كأنّ كلَّ مكانٍ كربلاء لدى |
عيني وكلَّ زمانٍ يومُ عاشورا |
____________________
(1) راجع نصوص الآيات الكريمة التالية: سورة الأعراف / 181، سورة آل عمران / 110، سورة الأعراف / 156 - 157.
ولكن القوّة لا تعمل إلاّ في حدود القوّة، ولا تجد فرصتها إلاّ في مسالكها، أمّا الشعور فبمكمن لا يتصّل به طغيان طاغية، ولا تحامل باطل، وفي هذا المكمن زرعت بذرة ثورة الحسين، وامتدّت فروعها فصارت فيئاً يستظلّه المضطهدون والمظلومون، فيجدون في فيئه الراحة والسكينة.
والثورة قدّمت طوق النجاة للمسلم الذي يريد الفوز بمرضاة الله، فصار واحداً من اُولئك الذين عناهم الرسول الأعظم بقوله: «مَثَل أهل بيتي كسفينة نوح؛ مَن ركبها نجا، ومَن تخلّف عنها غرق».
وليس المقصود في هذا القول الكريم (مَن ركبها) ركوباً مادّياً في حينها، أو (تخلّف عنها) تخلّفاً مادّياً في ساعتها، بل يشمل هذا المغزى كلّ الأجيال التي تُولد مؤمنة تستلهم سيرة أهل البيت وتسير على هَديها؛ فتكون كمَن تركب سفينتها لتنجو في أيّ وقت صحّت عزيمتها.
وثورة الحسين (عليه السّلام) هي السفينة التي مخرت عباب الباطل، ولم تزل في اليمّ حتّى الآن في رحلة بدأت أزليّة وتنتهي سرمديّة بانتهاء الدهور. وعجباً أن تكون هذه السفينة في العباب كلّ هذه القرون، لم تزدها حمولتها التي تثقل يوماً بعد آخر وسنة بعد اُخرى إلاّ خفّة ومضاء.
وفي رغبة الإنسان - أيّ إنسان كان - أن يركب هذه السفينة، معناه حمل لراية الكفاح التي رفعها الحسين، وهي راية للمسلم كما لغيره. فالرسول الأعظم (صلّى الله عليه وآله) لم يحدّد هويّة مَن يركب السفينة بالمسلم فحسب، بل بـ «مَن ركبها نجا، ومَن تخلف عنها غرق». وفي هذا التعميم شموليّة لبني الإنسان عامّة.
والمعنى المجازي في قولة الرسول (صلّى الله عليه وآله) ينفي الحرفيّة الكيفيّة عن القولة، فركوب سفينة آل البيت يتجلّى في رغبة العمل بمبادئ ثورة الحسين، والغرق بعيداً عن السفينة معناه
السكوت عن الظلم وتحريف العقيدة والعمل بروح بعيدة عن روح ثورة الشهيد، أمّا السفينة فهي المبادئ ذاتها التي نادى بها الحسين، فكان لها وَقْعَاً صارخاً في الضمائر جعلها تهبّ دفعة واحدة من سباتها العميق.
وعلى الرغم من تقادم العهد منذ قيام الثورة فإنّ الإنسان يسترجعها حارّة أمامه إذا ما نزعت نفسه إلى أخلاقيّاتها، متى دعته الحاجة وحلّت به المصائب وأناخت على خلقه مظالم حكّامه، فتعود إليه كما لو كانت متفجّرة لتوّها، فيشارك فيها مكافحاً بصبره على بلائه، ووقوفه في وجه الظالمين، وبرفضه لمنطق الهدم، فيكون بمقياس المعنى النبوي المقصود مشاركاً ثائراً كالقاسم وأخيه، والعباس وإخوته، وآل عقيل وعابس، والحَجّاج والسويد، وبرير والحرّ، وكلّ الذين جاهدوا جهاداً مادّياً إلى جانب الحسين وسقوا غرسة الشهادة في صحراء كربلاء بدمائهم الزكيّة.
وقد أخرج ابن ماجة وأبو يعلى عن الحسين (عليه السّلام) قال: «سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة وإن قدم عهدها، فيحدث لها استرجاعاً إلاّ أعطاه الله ثواب ذلك».
وفي عصر الضنك والظلم والتحريف هذا الذي نعيشه ما أحرانا لأن نتشرّف بالأخذ بالمبادئ الحسينيّة، ونجعلها لنا قانوناً حياتيّاً وأخلاقيّاً؛ فكم من يزيد الآن فوق سطح هذه الكرة الأرضيّة؟ وما أدرانا أن يكن أحدنا ابن زياد، أو ابن سعد، أو الشمر من حيث لا يدري إذا كان في ممارساته العصريّة ما يقرّبه من بعيد أو قريب لهؤلاء الشياطين المردة(1) ، فيكون كابن زياد عصره بعزوفه عن مبادئ
____________________
(1) في كثير من الأحيان نواجه نوعيّات شيطانيّة متلبّسة هيئات بشريّة. نتأكّد معها بأن يزيد وشمر وابن زياد وغيرهم يتكرّرون مجدّداً في كلّ عصر وزمن، ينتهكون الحقّ ويحلّون الحرام ويحرّمون الحلال. بينما ليس ثمّة حسين واحد فلنتأمّل في هذا.
الحسين، وكابن سعد زمانه بتهاونه مع الظالمين، وكشمر مكانه في عمله ضدّ مبادئ الحقّ والعدل، فيقتل الحسين من جديد في كلّ مرّة يقف فيها مع الباطل والزائف؟
فمبادئ الثورة الحسينيّة ليست شكلاً للحفظ فقط، تأخذ شاكلتها كأنّها مذهب صوفي أو تعليم نظري، بل هي شيء كالاستحواذ تتمدّد في القلب وتختلط في الفكر، فيغدو صاحبها قلباً وفكراً؛ لذا فإنّ أوّل ما مسّت هذه المبادئ من نفس الإنسان مسّت شعوره الإنساني وقلبه وفكره، فأيقظت هذه المكامن، فأحسّ بشعوره بالندم. وبقلبه بالتوبة وبفكره بضرورة التغيير.
وإذا كنت قد أسهبت في هذه المقدّمة قبل الخوض في معنى معجزات الثورات الزمنيّة التي اجترحتها شهادة الحسين؛ فذلك لاُبيّن مدى ما تفعله طفرة الإيمان الصادق في قرارة النفس البشرية، ولأوضّح على أنّ من معجزات الشهادة الاُخرى أنّها لا تقنع من أمرها بما حقّقته على مستوى ضمير الاُمّة وروحيّتها ومجتمعها، بل هي تكمل ذلك كلّه بتغيير الإطار الذي غيّرت في داخله هذه الصور الثلاث، ووجهتها الكمال تبغي من ورائه رفع الحقيقة بكامل جوانبها أمام الأعين، فلا تترك مجالاً لمشكّك ولا فرصة لمتخرّص.
وفي كمال الشهادة لحظة جلوة العقول والأنفس والضمائر آخر مرحلة من مراحل معجزاتها، حينما ترفع آخر غلالة شفافة فتبدو الحقائق أشدّ وضوحاً، فتنيل القائمين على أخذها شعوراً بالرضى عن ذواتهم.
ونِعْمَ الرضى إذا كان فيه ما يستوجب الشهادة مجدداً، فمعجزة الشهادة قد تتطلّب شهادة اُخرى، أو شهادات متواترة تفعل فعل النار فوق الحديد لا تنفكّ
تتأجّج حتّى يحمى الحديد ويصير قابلاً للمعالجة.
وكما بدأت الاستجابات الفوريّة لثورة الحسين على مستوى الشعور بالهزّة المبدئي، ثمّ تلتها مرحلة التبصّر في النفس والظروف والدوّامات، إلى أن وصلت إلى فترة الانفجار بعد أن مرّت بمرحلة كمون نفسي وضميري، فإنّ شكل الاستجابات للتغيير الزمني اتّخذ نفس مسار أصداء الثورة الاُولى.
وهكذا خفّ المتنادون من كلّ مكان وفي أحداقهم بقايا الكابوس الذي رانَ ثمّ عَبَر، وتوافدوا إلى مصدر النداء يذوبون في مجهوله دون معرفتهم بكُنهه إلى حيث يعالجون فيه داء ضمائرهم في انتفاضة تعيد لها العافية، وإلى حيث يجدّدون ثوابهم مع الله على نُصرة حُسينه في مبادئه، بعد أن خذلوه في خروجه المادّي للثورة.
وكان أوّل الملبّين لنداء المجهول جماعة أطلقت على نفسها (حركة التوّابين) حيث تلاقت وتشاورت وخرجت بنتيجة: أنّها قد أخطأت بترك الحسين دون نصرة، ورأى أنصار هذه الحركة أنّه لا مندوحة لهم من التكفير عن مقتل سبط النبي وذلك لا يحقّقه إلاّ قتل قتلته، وفزعوا لهذه الغاية إلى خمسة من وجهاء الشيعة بالكوفة وهم: سليمان بن صرد الخزاعي، والمسيب بن نجبة الغزاري، وعبد الله بن سعد بن نفيل الأزدي، وعبد الله بن وال التميمي، ورفاعة بن شداد البجلي.
وقد تداول الفزعون والمفزوع لهم بأمر ما كان من غرامهم بتزكية أنفسهم حتّى بَلا الله خيارهم، فوجدوا أنفسهم كاذبين في موطنين من مَواطن ابن بنت نبيّهم (صلّى الله عليه وآله) بعد أن بلغتهم كتبه، وقَدِمت عليهم رسله، وأعذر إليهم يسألهم نصرته عوداً وبدءاً، وعلانية وسرّاً، وما كان من موقفهم حيث بخلوا عنه بأنفسهم حتّى قُتل إلى جانبهم، فلا هم نصروه بأيديهم، ولا جادلوا عنه بألسنتهم، ولا قوّوه بأموالهم.
وفي جلسة المقارعة هذه مع الضمائر، صاح في الجمع سليمان بن صرد الخزاعي
الذي تولّى منصب الزعامة، قائلاً: ألا انهضوا، فقد سخط ربّكم، ولا ترجعوا إلى الحلائل والأبناء حتّى يرضى الله، وما أظنّه راضياً حتّى تناجزوا مَن قتله أو تبيروا، ألا لا تهابوا الموت فوالله ما هابه امرؤ إلاّ ذل، كونوا كالأُوَل من بني إسرائيل إذ قال لهم نبيّهم: إنّكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم، فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم.
وكانت صيحة سليمان بن صرد بمثابة إشارة البدء لانتفاضات لم تكن لتهدأ أو تخمد بالقوّة حتّى تتأجّج في مكان آخر.
وكانت (ثورة التوّابين) أوّل ردّة فعل لاستيقاظ الضمائر في اُمّة الإسلام، تَنادى لها شيعة المدائن والبصرة، وجمعت أنصاراً لها نفراً بعد آخر، ولم تكد تمضي باستدعائها فترة وجيزة حتّى مات يزيد، فاتّخذت الدعوة شكل الجهر بعد أن كانت سرّية.
حتّى إذا ما انقضت أربع سنين على تنادي التوابين للثورة، وخمس على استشهاد الحسين (عليه السّلام)، حتّى هبّوا هبّة ضمير واحد ورجل واحد يتناوحون ويبكون ندماً في ليلة جمعة على قبر الحسين (عليه السّلام)، ليندفعوا بعدها نحو الشام حيث أعملوا التقتيل في جيوش الاُمويّين حتى أُبيدوا عن آخرهم(1) .
والتهبت نار الثورات بعد حركة التوّابين التي اعتبرت حركة فجّرها الشعور بالتقصير والندم والرغبة الصادقة في التكفير، فلم تكن لتهدف وهي بهذا المنطلق إلاّ للانتقام، وقد شاركهم نفر من غير الشيعة آملين في تغيير الحكم الاُموي البغيض.
____________________
(1) تاريخ الطبري 4 / 426 - 436.
وإذا كان لهذه الانتفاضة من تأثير فإنّها أفلحت في شحن جماهير الكوفة وإيغار الصدور ضدّ الحكم الاُموي، وهذا ما ترجم بعد تفشّي خبر موت يزيد إلى ثورة على العامل الاُموي في الكوفة عمرو بن حريث وإخراجه من قصر الإمارة، وتنصيب عامر بن مسعود الذي بايع لابن الزبير، وفي تنصيبه انحسر سلطان الاُمويين لفترة من الزمن عن أرض العراق.
وبانحسار ثورة التوّابين بدا أنّ جرائر يوم عاشوراء بدأت في تصفية حساباتها والأخذ بحقّها وثاراتها.
ثورةُ المدينة
دأبت العقيلة زينب (عليها السّلام) منذ وصلت إلى المدينة بعد مقتل أخيها الحسين (عليه السّلام) على إلهاب الخواطر وشحن النفوس للثورة والتأليب على حُكم يزيد، ممّا دفع بعمرو بن سعيد الأشدق والي يزيد على المدينة لأن يكتب لسيّده عن نشاط زينب معتبراً وجودها بين أهل المدينة مدعاة لتهيّج الخواطر، ووصفها له بأنّها فصيحة عاقلة لبيبة(1) .
كان وجود العقيلة زينب في المدينة أحد الأسباب الرئيسة، ولكنّه لم يكن السبب المباشر للثورة، فقد تولّد هذا السبب بعد أن وَفَدَ إلى دمشق وفدٌ من أهل المدينة وأشرافها بأمر من عثمان بن محمّد بن أبي سفيان والي يزيد، وقد أكرمهم يزيد أيّما إكرام، ولكنّهم ما أن عادوا من لدنه حتّى أعلنوا استنكارهم لحكم يزيد وجاهروا بشتمه ولعنه وقالوا: قَدِمنا من عند رجل ليس له دين، يشرب
____________________
(1) هذه الرواية ذكرت في (أخبار الزينبيّات) وأوردتها بنت الشاطئ في (بطلة كربلاء).
الخمر، ويضرب بالطنابير، ويعزف عنده القيان، ويلعب بالكلاب، ويسمر عنده الخرّاب، وإنّا نشهدكم أنّا قد خلعناه.
وقام عبد الله بن حنظلة الأنصاري وكان زعيمهم وقال: جئتكم من عند رجل لو لم أجد إلاّ بنيّ هؤلاء لجاهدته بهم، وقد أعطاني وأكرمني، وما قبلتُ عطاءه إلاّ لأتقوّى به.
وهبّت المدينة واشتعلت ثورتها، فسلّط يزيد على الثوّار رجلاً اشتهر بحبّه للدماء وهو مسلم بن عقبة المري، وطلب منه أن يسوم الثائرين البيعة سوماً، فاستباح المدينة ثلاثة أيّام وهتك الأعراض وقتل الاُلوف من الأنصار والمهاجرين وافتضّ أكثر من ألف عذراء. كلّ ذلك من أجل أخذ البيعة التي أعلنها، إنّهم يبايعون أمير المؤمنين على أنّهم خول له يحكم في دمائهم وأموالهم وأهلهم ما شاء(1) .
وقد وصف ابن كثير المفاسد التي أنزلها مسلم بن عقبة بأهل المدينة بقوله: من المفاسد العظيمة في المدينة النبويّة ما لا يحدّ ويوصف، ولم يكتفِ بالقتل بل عمد إلى التنكيل وإثارة مخاوف قتلاه قبل قطع رؤوسهم بالسيف. ويُحكى: أنّه لمّا جاؤوه بمعقل بن سنان أحد أصحاب رسول الله (صلّى الله عليه وآله) هشّ له وأطعمه ثمّ سأله: أعطشت يا معقل؟ حوّصوا له شربة من سويق اللوز الذي زوّدنا به أمير المؤمنين. فلمّا شربها قال له بلؤم: أمَا والله لا تبولها من مثانتك أبداً، وضرب عنقه.
وقد مات هذا الجزّار وهو في طريقه إلى مكّة ليكمل ما بدأه من وحشيّة وإجرام في المدينة، فدفن في الطريق. ولكن بعض الغاضبين من أهل المدينة تعقّبوه واستدلّوا على قبره حيث نبشوه وأحرقوا جثّته.
____________________
(1) الطبري، ثورة المدينة 4 / 366 - 381.
ثورةُ المختار الثقفي
ولعلّها أقوى الثورات وأعنفها وأمضاها نتائج، إذ استطاعت أن تطيح بمعظم الرؤوس التي شاركت فعليّاً في قتل الحسين، ولقد جعل لها شعاراً بهذا المعنى (يا لثارات الحسين) وربطها بمحمّد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب، وهذا ما جعل الثائرين يلتفّون حوله، وقد اطمأنّوا إلى عدل ثورته وتمامها.
ولقد وقع عبد الله بن مطيع عامل ابن الزبير بالكوفة في خطأ قاتل حينما أقدم على محاربة الثائرين مع المختار بنفس الرجال الذين تولّوا قتل الحسين، بعمر بن الحَجّاج، وشمر بن ذي الجوشن، وشبث بن ربعي وغيرهم، ممّا أثار في نفوس الثائرين كوامن الانتقام، وذكّرهم بالجريمة النكراء التي اقترفها هؤلاء في كربلاء، فكان هذا كافياً لإثارة عنفهم الذي تبدّى فيما بعد.
وكما وقع ابن مطيع بمقتل، أنصف المختار بتوليه الحكم في طبقة (الموالي) وهم المسلمون غير العرب الذين كان عليهم واجبات المسلمين ولم تكن لهم حقوقهم، وكان الاُمويّون يضطهدونهم. وقد أثار إنصاف المختار لهم حفيظة الأشراف وسادة القبائل فتكتّلوا ضدّه وأجمعوا على حربه(1) .
وكان تكتّلهم سبباً حفّز المختار للتعجيل في تتبّع قتلة الحسين وآله في كربلاء، فتعقّبهم وأعمل فيهم القتل، ولم يترك منهم مَن أحصى عليه ضربة أو كلمة في كربلاء وما قبلها وما بعدها(2) .
وكان عنيفاً مع اُولئك الذين شاركوا في مجزرة كربلاء، فلم يترك ضارباً أو متكلّماً أو
____________________
(1) تاريخ الطبري 4 / 517.
(2) ذكرت عدّة مصادر ومنها الطبري: أنّ المختار قتل في يوم واحد مئتين وثمانين رجلاً.
ناهباً إلاّ وأوقع عليه عنفه، فقتل عبيد الله وأحرقه، وقتل شمر بن ذي الجوشن وألقى أشلاءه للكلاب، وطارد المئات والاُلوف من جندهم وأتباعهم، فأغرقهم بالنهر، ولم ينجَ من غضبه عمرو بن الحجّاج وشبث بن ربعي وغيرهم.
وكانت هذه القسوة التي تبدّت في ثأر المختار إحدى حكم معجزات الشهادة التي أدّاها سيّد الشهداء، فكانت العدل الكامل في ثوب الإبادة، وكانت قصاصاً بآثمي العاشر من محرّم استحقّت الثناء والمباركة.
وكان قصاصاً اتّخذ له من اُولئك الآثمين في محرّم وقوداً، وجعل من جوف الكلاب قبراً للكلب الأبقع شمر الذي رآه الحسين في منامه يشدّ عليه أكثر من غيره. فسبحان القادر مسيّر الأحوال، وموحي القصاص، ومدبّر العدل.
ثورةُ مطرف بن المغيرة
ولم تنقضِ سنوات معدودة على ثورة المختار حتّى كان مطرف بن المغيرة بن شعبة يثور على الحَجّاج بن يوسف ويخلع عبد الملك بن مروان والي الحَجّاج على المدائن.
وقد كتب إلى أنصاره يدعوهم إلى كتاب الله وسنّة نبيّه وإلى جهاد مَن عَنَدَ عن الحقّ، واستأثر بالفيء، وترك حُكم الكتاب؛ وذلك ليظهر الحقّ ويمنع الباطل. ولا بدّ للمتبصّر في دعوة مطرف من ملاحظة استمدادها روح كربلاء.
ثورةُ ابن الأشعث
وتستمرّ روح كربلاء في التفاعل بين المجتمعات، وتمتدّ نارها إلى تحت
العروش، فلا تستكين الجماعات حيث تصلها هذه الروح، ولا تبقى عروش حيث تصلها النار.
فبعد أن قمعت المدينة وانتفاضة الكوفة، تأجّجت في سنة 81 للهجرة ثورة بقيادة ابن الأشعث هزّت الحكم الاُموي الذي كان على رأسه الحَجّاج، ودامت حتّى عام 83 بعد أن أحرزت انتصارات ضخمة قبل أن يقضي عليها الحَجّاج بجيوش سوريّة(1) .
ثورةُ زيد بن علي بن الحسين
وقد بدأها في سنة 122 هـ على هَدي ثورة جدّه، مقتبساً روحها في كربلاء، وقد رفع لها شعاراً(يا أهل الكوفة، اخرجوا من الذلّ إلى العزّ، ومن الدنيا إلى الدِّين) (2) .
وقد استجابت لدعوة حفيد الشهيد الحسين جماهير عريضة في طول البلاد الإسلاميّة وعرضها، فبويع على الثورة في الكوفة والبصرة وواسط والموصل وخراسان والرَي وجرجان، وكان مقدّراً لهذه الثورة أن تكون أكبر الثورات المتفجّرة من شرارات كربلاء لولا أن تمّ إعلانها قبل موعد استكمال تجهيزها، وفي توقيت مختلف عن التوقيت المتّفق عليه بين زيد وبين أهل الأمصار التي لبّت دعوته.
وقد تعرّضت هذه الثورة لأخطار عدّة؛ بسبب الجيش الاُموي السوريّ الذي كانت قواعده في العراق، إذ ما لبث هذا الجيش أن قضى عليها قبل أن تبدأ فاعليتها.
____________________
(1) حلّل هذه الثورة المؤرّخ ولها وزن في كتابه (الدولة العربيّة) / 189 - 203 وذكرها الطبري في (ثورة ابن الأشعث).
(2) مقاتل الطالبيّين / 139 والدولة العربيّة / 271.
وكان من نتيجة هذه الحركة أن تولّدت منها طائفة تُدعى (الزيديّة) برهنت على استعدادها للاشتراك في كلّ ثورة ضدّ السلطة الغاشمة.
واستمرّت الثورات هنا وهناك آخذة شرارات اشتعالها من شرارات كربلاء المتّقدة أبداً، ولم يعد للحكم الاُموي من شاغل إلا ّالتصدّي لها واستنباط الوسائل للقضاء عليها.
وجاءت ثورة العبّاسيين لتضع الخاتمة النهائيّة لتفجّر الثورات التي استهدفت الحكم الاُموي الذي كان مثالاً لفساد الحكم والعروش. واستطاعت بما رفعته من شعارات وتزوّدت به من مبادئ الكفاح الحسيني أن تنتصر في النهاية وتطيح بحكم بني اُميّة، فإذا بالدولة الاُمويّة العريضة ذات العدد والعدّة تذهب بلا وناء في وقت أقلّ من عمر رجل مثل معاوية.
ورغم أنّ ثورة العبّاسيين لم يكن لها ذلك الدَور الجذري في تبديل واقع الشعب المسلم، فيما عدا تبديلها للحاكمين فوق العروش، فإنّ بنجاحها هذا لم تتوقّف الثورات بعدها، بل استمرّت مشتعلة أبداً، إذ قد توفّر للعروش دوماً أشباه ليزيد، بينما ثمّة حسين واحد كان لعِظَم وخلود مبادئه أن كانت تلد في كلّ يوم ولكلّ جيل ثائرين جدداً يتصدّون للعمل بنورها العلوي، ورفع راية الجهاد الحسيني الذي أضحى سِمة لكلّ جهاد في كلّ زمان ومكان نبت فيهما يزيد جديد.
وهكذا تمّت معجزات الشهادة التي أقدم عليها الحسين (عليه السّلام) وآله وصحبه الأطهار، وبلغت مداها - وإن لم تتوقّف عنده - بالثورات الزمنيّة التي هدّت عروش الظلم وأطاحت بحكم كان من المستحيل الإطاحة به لولا ما قدّمته شهادة الطفّ من معجزات كان لها فعل السحر في النفوس والضمائر والمجتمعات.
وإذا كانت معجزات استشهاد عيسى (عليه السّلام) قد تشابهت مع معجزات شهادة الحسين (عليه السّلام) في فعلها داخل الضمائر والأخلاق والمجتمع، فإنّها لم تتشابه معها في المعجزة الزمنيّة التي تمثّلت في سقوط الحاكمين، إذ انتهت شهادة المسيح عند حدود الضمائر والأخلاق ومناطق العقيدة، بينما تجاوزتها شهادة الحسين إلى إتمامها بمعجزات زمنيّة؛ وذلك لحكمة إلهيّة تدبّر وتسيّر.
فمن عجائب هذه الحكمة أن تجري هذه الحوادث والثورات التي تلت الشهادة كَلِماً على لسان مَن وقعت بجريرة قتله، وذلك قبل وقوعها بعشرات السنين بنفس الشكل الذي صوّره الشهيد وكأنّه يقرؤها في لوح مكشوف أمام عينيه.
فبعد أن أنزل الله تعالى المذلّة على مَن أهانوا وقتلوا شهيده الحسين (عليه السّلام)، فغدوا أذلّ من قوم سبأ، تذكّر المسلمون نبوءة شهيدهم التي قالها ببني اُميّة في الرهيمة: «إنّ بني اُميّة شتموا عرضي فصبرت، وأخذوا مالي فصبرت، وطلبوا دمي فهربت. وايم الله لَيقتلوني فيلبسهم الله ذلاً شاملاً، وسيفاً قاطعاً، ويسلّط عليهم مَن يذلّهم(1) حتّى يكونوا أذلّ من قوم سبأ؛ إذ ملكتهم امرأة فحكمت في أموالهم ودمائهم»(2) .
تذكّر المسلمون هذه النبوءة واسترجعوا صور الذلّ التي ألبسها الله لبني اُميّة، وكيف أهينوا وشرّدوا وولّوا هاربين متعقّبين وقُتلوا بأعداد هائلة ومُثّل بهم، وأُنزلت بهم فظاعات من التنكيل لم تكن لتخطر ببال بني اُميّة ولا ببني هاشم يوم صُرع الحسين(3) .
____________________
(1) أمالي الصدوق / 93، المجلس الثلاثون.
(2) روي الحديث بتمامه في مقتل الخوارزمي 1 / 226 ومثير الأحزان - لابن نما.
(3)( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ) (سورة النساء / 93).
وفي المواقف المتشابهة تبرز الكلمات التي قيلت، سيّما إذا كانت تحمل استشفافاً بعيداً للمستقبل، فقد تذكّر المسلمون قولة شهيدهم أمام ولده وأخواته وأهل بيته يوم نزل بكربلاء قال وهو يبكي: «اللّهمّ إنّا عترة نبيّك محمّد قد اُخرجنا وطُردنا وأُزعجنا عن حرم جدّنا، وتعدّت بنو اُميّة علينا، اللّهمّ فخذ لنا بحقّنا وانصرنا على القوم الظالمين»(1) .
وأخذ الله تعالى بحقّ المكروب والمبتلى بكربلاء، وكانت أيّما أخذة بالحقّ، تطايرت بها رؤوس بني اُميّة التي تعدّت على عترة النبي وأخرجتها وأزعجتها، فلم يرَ مظلوم أخذ حقّه بمثل ما أخذ حقّ المظلوم الحسين من القوم الذين ظلموه(2) .
وقد روى الحاكم في مستدركه قولاً للخطيب عن ابن عباس فقال: أوحى الله تعالى إلى محمّد: إنّي قتلت بيحيى بن زكريّا سبعين ألفاً، وأنا قاتل بابن بنتك سبعين ألفاً وسبعين ألفاً.
وكأنّ سبحانه وتعالى لمّا رأى عِظَم عذاب الحسين أعطاه سلطة وضع نهايات ظالميه بالشكل الذي يتصوّره ويصرّح به، وهذا ما يفسّره وقوع كلّ ما تنبّأ به وحذّر منه اُولئك الذين لطّخوا أيديهم بدمه ودماء أهل بيته.
وما قاله للذين يحيطون به من جند الأعداء في صحراء كربلاء قبل بدء المعركة، ليدخل في عِداد المعجزات التي ما اُوتيت إلاّ لعيسى (عليه السّلام)، فكأنّ الزمن
____________________
(1) (لاَ يَنْهَاكُمْ اللهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ)(سورة الممتحنة / 8 - 9).
(2) (... وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً...) راجع نصّ الآية (سورة الإسراء / 33).
تصرّم واختزل، وكأنّ عشرات السنين ليست بذي بال حيال ما قاله الشهيد للذين وقفوا يسمعونه، فكان من أمرهم بعد ذلك لا يختلف مقدار شعرة عمّا رسمه لهم من مصائر ونهايات.
قال لأعدائه: «أمَا والله لا تلبثون بعدها إلاّ كريثما يركب الفرس، حتّى تدور بكم دور الرحى، وتقلق بكم قلق المحور؛ عهدٌ عَهده إليَّ أبي عن جدّي رسول الله. فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثمّ لا يكن أمركم عليكم غمّة، ثمّ اقضوا إليَّ ولا تنظرون، إنّي توكّلت على الله ربّي وربّكم، ما من دابّة إلاّ هو آخذ بناصيتها إنّ ربّي على صراط مستقيم(1) . والله لا يدع أحداً منهم إلاّ انتقم لي منه؛ قتلة بقتلة وضربة بضربة، وإنّه لينتصر لي ولأهل بيتي وأشياعي»(2) .
فماذا يمكن أن نسمّي هذا القول؟ نبوءة، رؤيا، سلطة علويّة خاصّة بالشهداء الأبرار، نفحة من السرّ الإلهيّ للمختارين؟ وإلاّ فكيف دالت الاُمور بعد سنوات معدودة من قول هذه الكلمات إلى نفس الشكل الذي حدّدته، وبنفس الكيفيّة التي جاهرت بها، فكانت القتلة بقتلة والضربة بضربة؟
ولنسمع الشهيد يكمل استقراء مستقبل الأيّام فيقول (عليه السّلام): «اللّهمّ احبس عنهم قطر السماء، وابعث عليهم سنين كسنيّ يوسف، وسلّط
____________________
(1) مقتل الحسين - المقرّم / 287 عن تاريخ ابن عساكر 4 / 334 واللهوف / 54.
(2) مقتل العوالم / 84.
عليهم غلام ثقيف(1) يسقيهم كأساً مصبّرة».
فكانت السنوات التي وقعت بين تاريخ مقتله وتاريخ سقوط آخر أمير اُموي ألعن من سني يوسف؛ تسلّط خلالها عليهم مَن هم أقسى من غلام ثقيف، فأذاقهم (زقاً) مصبرة، ولم يكتف بكأس واحدة، فتبدّد شملهم واندثر ذكرهم.
وكانت صرخته التي راحت شعاراً للثورة والمظلومين: «أمَا من مغيثٍ يغيثنا! أمَا من مجيرٍ يجيرنا! أمَا من طالب حقّ ينصرنا! أمَا من خائفٍ من النار فيذبّ عنّا!». قد أضحت أمراً لكثيرين كي يهبّوا لإغاثة مبادئه، فازداد المجيرون، وكثر طلاّب الحقّ المناصرين لحقّه، وصار عدد الخائفين من النار أكثر من عدد رمل البحر؛ يذبّون عن العقيدة التي تكلّم باسمها وعنى بها قوله (يذبّ عنّا)، فانقلبت الموازين، وغدا شعار إغاثة الحسين وإجارته ونصرته والذبّ عنه ناموساً وشريعة لدى كلّ المؤمنين؛ سواء أكانوا مسلمين، أو تحت أيّ دين أو عقيدة انضووا، وفي كلّ عصر ومصر، وغدا الحسين رمزاً وشعاراً واستلهاماً واُسلوباً.
ولئن تحدّثنا عن نبوءات الحسين التي تحقّقت بعد ردح من الزمن، فإنّنا لن نغفل ما ألهمته هذه النبوءات للعقيلة زينب (عليها السّلام)، من استقراء للمستقبل القريب وهي التي كانت قريبة على الدوام من أخيها تسمع كلّ ما يلفظه فوه من كلام، وكانت تحفظ في قلبها استلهام أخيها الشهيد، فيوحي لها هذا الاستلهام بكلّ ما تلفّظت به كاستقراء للمستقبل.
فها هي في واحدة من هذه الاستقراءات، حينما وقفت أمام يزيد وقالت له:
____________________
(1) هو المختار بن أبي عبيدة الثقفي.
اللّهمّ خذ لنا بحقّنا، وانتقم ممَّن ظلمنا، واحلل غضبك بمَن سفك دماءنا، وقتل حماتنا.
وإذا كان في قولتها هذه دعاء عامّ لكلّ مَن ظلمهم وقتل حماتهم، فإنّها هنا في هذه القولة تحدّد أكثر فتقول موجّهة كلامها ليزيد: فوالله ما فريت إلاّ جلدك ولا حززت إلاّ لحمك، ولتَرِدَنّ على رسول الله وآله بما تحمّلت من سفك دماء ذريّته وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته، حيث يجتمع شملهم، ويلمّ شعثهم، ويأخذ بحقّهم.
وهكذا أيضاً لم تشذّ الاُمور في ما تلا من أيّام عن هذا الاستلهام قيد أنملة، فكان يزيد ممَّن حزّ لحمه وفري جلده بيده، ودلّت ميتته وما تلاها على بعض ما ينتظره في الآخرة عندما يُحشر يوم القيامة ويُسأل عمّا تحمّله من سفك دماء عترة النبي (صلّى الله عليه وآله).
ولعلّ الإلهام المستقرّئ للمستقبل كان في عبارة العقيلة ليزيد واضحاً محدّد المعالم بشكل غريب إذ قالت له: فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، ولا يرحض عنك عارها، وهل رأيك إلاّ فند، وأيّامك إلاّ عدد، وجمعك إلاّ بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين.
وقالت وهي مسبيّة: المستقبل لذكرنا، والعظمة لرجالنا، والحياة لآثارنا، والعلوّ لأعتابنا، والولاء لنا وحدنا.
وقالت لابن أخيها السجّاد قبل أن يترك ركب السبي أرض كربلاء: فوالله إنّ هذا لعهد من الله إلى جدّك وأبيك، إنّ قبر أبيك سيكون علماً لا يُدرس أثره، ولا يُمحى رسمه على كرور الأيّام والليالي، وليجتهد أئمّة الكفر وأشياع الضلال في محوه
وتطميسه، فلا يزداد أثره إلاّ علوّاً(1) .
وقد برهنت الأيّام وتكرار القرون على صدق هذا الاستقراء، فلم يرحض عار الجريمة عن يزيد حتّى فتكت به وراح بجريرتها، فكانت أيّامه عدداً وجمعه بدداً.
وكان المستقبل لذكر آل البيت (عليهم السّلام) مرهوناً، والعظمة لرجاله موقوفة، والحياة لآثارهم ناصعة، والعلوّ لأعتابهم يزداد، والولاء لهم وحدهم يتعمّق.
واحتلّ قبر الحسين الشهيد كعلم لا يُدرس أثره في الضمائر قبل الأرض، ولم يزده كرور الليالي والأيّام إلاّ رسوخ رسمه، وما زادته اجتهادات أئمّة الكفر وأشياع الضَلال إلاّ بروزاً وتثبيتاً، فازداد أثره علوّاً.
ولنَجِل عيوننا الآن إذا كنّا في شكّ من تمام هذه المعجزات التي اجترحتها شهادة سيّد الشهداء، لنَجِلها في كلّ البقاع والأصقاع باحثين عن أيّ أثر ليزيد أو معاوية أو شمر أو ابن زياد، فلا يمكن أن نعثر على أيّ أثر لهؤلاء، فقد اندرست آثارهم، وانمحى ذكرهم، وإذا ذكروا فلأجل لعنهم والدعاء لهم بنارٍ حامية لا تنطفئ.
ولنَجِل أبصارنا بالمقابل إلى أيّ مكان فوق هذا الكوكب، فيطالعنا خلود الحسين ونسمع اللهج بذكراه. ففوق كلّ مكان الحسين منارة هَدي، وفوق كلّ يمّ الحسين طوق نجاة، وفي كلّ مظلمة الحسين قبس من نور وحكمة، وأمام كلّ طاغية الحسين ثورة لا تبقي ولا تذر.
هو (عليه السّلام) ملء الأبصار والأسماع، أمل للحائرين والمظلومين، وبلسم
____________________
(1) كامل الزيارات / 261.
للمجروحين المحزونين، وشفاء لكلّ علّة اجتماعيّة وأخلاقيّة.
ولنرى الآن أين اُولئك الظالمون؟ وأين قبورهم؟ وكيف يُذكرون؟(1) لنقتنع بعظمة أقوال السبط العظيم، وبخلود مبادئه خلود الإنسان الذي كانت لأجله.
ويكفي يزيد مهانة أن يعلن ابنه معاوية الثاني أمام حشدٍ كبير براءته ممّا جنت أيدي أبيه وجدّه، ورفضه الجلوس على عرش ملوّث بدماء الحسين. ويكفي الحسين خلوداً وتكريماً أن يعلن ابن قاتله عن حمل شعلة ثورته والعمل بوحي من مبادئه.
ولنرى الآن كيف يكرّم المؤمنون على اختلاف أديانهم الحسين (عليه السّلام)، وكيف يستلهمون ثورته في قيامهم وقعودهم(2) ، في صغائر اُمورهم الدنيويّة وكبائرها؟
فلنمجّد لله الذي كان رفوقاً بعباده إذ أعدّ لهم طوق خلاصهم، ورفع أمام بصائرهم الكليلة منارة الفضيلة والحقّ بشخص الحسين الشهيد. وإنّها لعبرة ودرس علوي لبني البشر؛ كي لا يعموا بصائرهم ويصمّوا آذانهم عن دعوات الحقّ التي يرسل لها تعالى أربابها لحكمة فوق مستوى إدراكهم.
قالت عزّته: وكما عَلَت السماوات عن الأرض كذلك طُرقي عَلَت على طُرقكم، وأفكاري على أفكاركم(3) .
ونهضة الحسين (عليه السّلام) هي السفينة التي عناها الرسول الكريم، فمَن يركبها ينجو، ومَن يتخلّف عن ركوبها يغرق.
____________________
(1) قيل: إنّ يزيد مات أثناء تلهّيه بالصيد في (حوّارين) من بلاد الشام. ولم يعثر من جثّته إلاّ على فخذه، فنقلت إلى دمشق ودفنت قرب الباب الصغير اليوم في غرفة مهجورة ليس لها سقف، يرميها المارّون بالحجارة ويبصقون على العظام التي تضمّها، تبرّؤوا من يزيد ومن أفعاله المنكرة.
(2) ذكرى عاشوراء تجديد لهذا الاستلهام، وإعادة لذكرى الفداء العظيم الذي أنقذ دين الإسلام من الفناء.
(3) أشعيا 55 / 9 - 10.
فما أجدر بالبشريّة وهي تجتاز في هذا العصر المظلم أخلاقيّاً واجتماعيّاً وسلطويّاً درب آلامها لأن تتوجّه نحو منارة الحسين كي لا تضلّ، وتتمسّك بأطواق مبادئه كي لا تغرق، وتسترشد بصرخته كي تبعد عنها وحوش الضلالة وثعابين الظلم والإذلال.
وما أحرانا الآن أكثر من أيّ وقت مضى لأن نستدفئ بحرارة قتل الحسين المنبعثة من قلوبنا حارّة لا تبرد أبداً. وهي حارة تستوطن قلوبنا، ولا داعي للبحث عنها بعيداً عن صدورنا، فهي جزء من حرارة قلوبنا، إذا كنّا مؤمنين.
ولنا في قولة الرسول الكريم (صلّى الله عليه وآله): «إنّ لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبداً» دافعاً لإدراك حقيقة جوهريّة لطالما تغافلنا عنها، وهي أنّ حرارة قتل الحسين قد احتلّت قلوبنا وامتزجت في دمائنا وصارت خليّة من خلايانا، ولو لم تكن حرارته كذلك لَما أعطاها الرسول الكريم صفة الحتميّة التي لا تتحمّل تأويلاً.
فصلوات الله عليه لم يقُل: ستظلّ حرارة قتل الحسين حارّة فيعطيها صفة المرحليّة، ولم يقُل: اجعلوها حارّة في قلوبكم فيعطيها صفة البدء، ويعطينا خاصيّة الاختيار والتقرير بين جعلها حارّة أو تركها باردة، ولم يقُل: يجب أن يكون لقتل الحسين حرارة فيربطها بإرادة الإنسان، فتخضع لمبدأ الوجوب أو عدمه، بل كان في قولته (صلّى الله عليه وآله) تضمين حتمي بأنّ لقتل الحسين حرارة لا تبرد أبداً، وهو تضمين لا يحمل صفة التعمية أو اللبس، بل هو تأكيد مجزوم بأنّ قلب المؤمن هو مقرّ ومستقرّ حرارة استشهاد الحسين؛ لأنّ سدى هذا الاستشهاد من لحمة إيمان قلب المؤمن، فهو إذاً لا يحيا إلاّ بهذه الحرارة، وهذه الحرارة لا تتأجّج حيث لا تبرد
أبداً إلاّ في هذا القلب(1) .
قولة نبويّة فيها من إعجاز الحكمة الشيء الكثير لو عملنا بمقتضاها لتبدّلت حياتنا، وما أظنّ إلاّ أنّا عاملون بهذا المقتضى ملتفتون إلى ما فيه من جوهر، فحتمية اندفاعتنا العصريّة وما يحيق بها من مظالم وقهر ستؤول بنا في النهاية إلى حظيرة الحسين، حيث نجد فيها العدل والرحمة والطمأنينة، وننفض عن ذاتيّتنا كلّ وهنٍ وخوفٍ وشكٍّ.
فمَن أحقّ من المؤمن في الاستفادة من نتائج شهادة الحسين، ومَن أحقّ منه في الدفء المنبعث من هذه الشهادة، حيث يذوب أمامه صقيع أوهامه؟ فهلاّ كنّا من المؤمنين الذين كرّمهم تعالى بأن جعل لقتل الحسين في قلوبهم حرارة لا تبرد أبداً؟ وهل نحن أهلٌ لهذه التكرمة؟ وجديرون حقّاً بهذه الحرارة؟
قبل الإجابة لنسأل أوّلاً: هل وعَينا هذه الحرارة؟ وهل تأكّدنا من وجودها في قلوبنا(2) ؟
____________________
(1) حرارة المشاعر في القلوب هي المُلهم للفكر والمحرّك لإرادة الفعل. وفي استيلاء حرارة الحبّ في القلب المُحبّ دافعاً له لإظهار مودّته وعطفه نحو محبوبه بقدر كبير من الجزل والحبور. وحرارة قتل الحسين (عليه السّلام) المستوطنة في قلوبنا تؤجّج في أفكارنا إلهامات إنسانيّة خيّرة. وفي قلوبنا التماعات قدمية عذبة، فننحو نحوها بجوارحنا لنذوب في نداء مجهولها، فتخضوضر مناطق اليبوسة في حنايانا. وفي هذا سرّ الحرارة والتأجّج.
(2) التأكّد يكون بعدّة مظاهر أوّلها القدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة المظلوم.
الأسبابُ البعيدة للثورة
بواعث الثورة لدى الحسين لم تبدأ في عصره وعصر خصمه يزيد، بل كان لها جذور تاريخيّة بدأت منذ عهد قروم عبد مناف، ثمّ إلى قريش. فالهاشميّون والاُمويّون من اُرومة واحدة، إلاّ أنّهم يختلفون عن بعضهم بالأخلاق والمُثُل؛ إذ كان بنو هاشم أخلاقيّين أريحيّين، بينما بنو اُميّة نفعيّون دهاة سيّما مَن كان منهم في أصل عبد شمس من الآباء.
ولعلّ خير وصف للأُسْرَتَين ذلك الذي قاله نفيل بن عدي لمّا تنافر له عبد المطّلب وحرب بن اُميّة، فقال لحرب:
أبوك مُعاهرٌ وأبوه عفٌّ |
وذادَ الفيلَ عن بلدٍ حرامِ |
وكان نفيل يشير إلى فيل أبرهة الذي أغار به على مكّة، ويعني عن اُميّة بـ(معاهر) لِما عُرف عنه من تعرّضه للنساء، وما أشيع من أنّه ضُرب مرّة بالسيف لتعرّضه لامرأة من بني زهرة.
ولعلّ اختلاف الأمزجة والأخلاق هو الذي حدّد مسار أجيال أبناء هاشم وأبناء عبد شمس، فقد عُرف عن بني هاشم تعلّقهم وعملهم في القيادة الدينيّة، وعُرف عن عبد شمس عملهم في التجارة والسياسة.
وإذا اختلفت الأمزجة والطبائع بين البشر فلا بدّ من اختلاف النظرة إلى الاُمور، وإلى كيفيّة أخذها تبعاً لذلك؛ لذا كان من المحتّم أن تقوم المواجهة السافرة حيناً، والمبطّنة حيناً آخر بين فروع العائلتَين المنحدرتَين من عبد مناف.
وطبيعي إذا ما تفجّرت مثل هذه المواجهة وتفاقم بين الأُسْرَتَين الخلاف أن يعرف المطّلع - وقد خَبُر فارق الطبائع والأمزجة - مَن سيكون المعتدي، ومَن سيكون المعتدى عليه، ومَن يأخذ جانب الباطل، ومَن يأخذ جانب الحقّ.
ولو عرضنا هذا الأمر على مطلق إنسان لأجاب: بأنّ النفعي هو ممثّل الباطل، والأريحي هو ممثّل الحقّ. وعلى نفس المقياس يجيب أيضاً: بأنّ التاجر والسياسي هو مشعل فتيل الخلاف، على القائد الديني وداعية الأخلاق.
وإذا كان من غير المناسب أن نخوض في الأسباب التاريخيّة لخلاف بني هاشم وبني اُميّة في متن كتابنا التحليلي هذا، تاركين هذه المهمّة لكتب التاريخ الصرفة التي تهتمّ بسرد الحوادث دونما تحليلها وإبداء الرأي حولها، فإنّ ذلك لن يمنعنا من تقديم نبذة بسيطة عن هذا الخلاف مذ تفجّر حتّى وصلت نتائجه إلى عهد الحسين ويزيد، وما كان من الحوادث التي تلت.
وما دمنا لا نبغي التركيز على تلك الفترات التاريخيّة إلاّ فيما ينفعنا لمادّة هذا الكتاب الذي نتوجّه به للفكر المسيحي العربي والغربي أوّلاً، وللفكر الإسلامي ثانياً، فإنّ في تعريجنا السريع على تلك الفترة من شأنه إكمال الصورة المجزّأة لملحمة كربلاء، وما سبقها من أسباب وبواعث وأحداث، ما دمنا قد أكملنا الأجزاء التي تلتها، فصار
لزاماً علينا وضع الأجزاء التي سبقتها لإكمال صورتها النهائيّة.
صراعُ موروث
جذور الخلاف الاُولى تمتدّ إلى صراع موروث وتخاصم حاد منذ عهد الجاهليّة الاُولى بشرارة بدأت بين هاشم واُميّة، وامتدّت بين محمّد (صلّى الله عليه وآله) وأبي سفيان، واستمرّت إلى عهد علي ومعاوية، وانتهت بعهد الحسين ويزيد.
وقد جاءت وفاة النبي (صلّى الله عليه وآله) لتكشف عن استمراريّة تمكّن روح القبليّة بين المسلمين، إذ لم تمضِ ساعات على وفاة الرسول الأعظم حتّى بدأت المداولات هنا وهناك بمعزل عن جموع اُمّة الإسلام العريضة، وكلّها تبحث في مسألة الخلافة بعد النبي (صلّى الله عليه وآله).
فرأى الأنصار بأنّ الخلافة من حقّهم، ونازعهم فريق قريشي هذا المنطق. وكان عامل الذهول الذي أصاب المسلمين بوفاة النبي (صلّى الله عليه وآله) قد جعلهم يتناسون عهد النبي إلى علي بن أبي طالب (عليه السّلام). وكانت هذه الروح القبليّة التي تأجّجت يوم السقيفة هي البذرة الاُولى للفتنة التي نشبت بين المسلمين.
وحينما تولّى عمر الخلافة فرض العطاء على مبدأ التفضيل، ففضّل السابقين على غيرهم، وفضّل المهاجرين على الأنصار، والعرب على العجم، والصريح على المولى، ومضر على ربيعة، والأوس على الخزرج(1) .
____________________
(1) شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد 8 / 111، وتاريخ اليعقوبي 2 / 106، وفتوح البلدان / 437.
ولكن عمر ما كاد يدرك أخطار مبدئه هذا، السياسيّة منها والاجتماعيّة والدينيّة، ويرغب في تغييره، حتّى اغتيل(1) ، وخلفه عثمان وسار على نفس نهجه السابق.
وما عتمت الأحداث أن تطوّرت، وانقسمت الاُمّة الإسلاميّة إلى صفَّين؛ فكانت قريش - عدا بني هاشم - مع عثمان، والأنصار مع علي. ولعلّ أصدق موقفَين يصوّران حالة الجدل التي تفشّت وقتذاك هذان الموقفان: فقد قال عبد الله بن سعد بن أبي سرح الاُموي: أيّها الملأ إذا أردتم ألاّ تختلف قريش فيما بينها فبايعوا عثمان(2) .
وقال عمّار بن ياسر: إن أردتم ألاّ يختلف المسلمون فيما بينهم فبايعوا عليّاً(3) . ولمّا كان علي (عليه السّلام) مرشّح الأكثريّة المسلمة، وعثمان مرشّح الأرستقراطيّة القرشيّة، فقد فاز عثمان بالبيعة دون علي.
ومنذ ذلك اليوم دخل الاُمويّون في الحكم، وكان من نتيجة فوز عثمان أن صار أي مرشّح يرجو الخلافة لنفسه بعد أن رشّحه لها عمر. وقد وصف هذه النتيجة علي (عليه السّلام) بقوله: «لأسلمن ما سلمت اُمور المسلمين، ولم يكن فيها جَور إلاّ عليَّ خاصّة»(4) .
وقد تفاعلت هذه الأحداث مع سياسة عثمان الفاسدة في المال والإدارة والحكم
____________________
(1) في تاريخ اليعقوبي، وشرح نهج البلاغة قال عمر: إن عشتُ هذه السنة ساويتُ بين الناس، فَلَم أفضّل أحمر على أسود ولا عربياً على عجمي، وصنعتُ كما صنع رسول الله وأبو بكر.
(2) و (3) شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد 9 / 59، وتاريخ الطبري 4 / 232 - 233.
(4) نهج البلاغة 1 / 151.
فبدأ الانحراف الصريح في العقيدة ومبادئ الإسلام من يومها.
وقد ازداد الفساد في عهده فضرب كلّ الولايات الإسلاميّة، ممّا ألّب جموع المسلمين عليه فتنادوا إلى الثورة ضدّه بعد أن ضيق بأعمالهم، وبعثهم إلى أرض العدو كجنود - وجمّرهم - أي جمّدهم هناك، وحرم أعطياتهم ليطيعوه، ولكن هذه الأحداث انتهت بمقتل عثمان(1) .
ولايةُ علي (عليه السّلام)
بعد مقتل عثمان جاءت الجموع تطالب علياً بتولّي الحكم، لكنّه أبى عليهم ذلك؛ لأنّ للحكم تبعات سيّئة بعد ولاية عثمان، لذا قال لهم: «دَعُونِي وَالْتَمِسُوا غَيْرِي؛ فَإِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ أَمْراً لَهُ وُجُوهٌ وَأَلْوَانٌ، لا تَقُومُ لَهُ الْقُلُوبُ وَلا تَثْبُتُ عَلَيْهِ الْعُقُولُ، وَإِنَّ الآفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ وَالْمَحَجَّةَ قَدْ تَنَكَّرَتْ. وَاعْلَمُوا أَنِّي إِنْ أَجَبْتُكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا أَعْلَمُ، وَلَمْ أُصْغِ إِلَى قَوْلِ الْقَائِلِ وَعَتْبِ الْعَاتِبِ، وَإِنْ تَرَكْتُمُونِي فَأَنَا كَأَحَدِكُمْ، وَلَعَلِّي أَسْمَعُكُمْ وَأَطْوَعُكُمْ لِمَنْ وَلَّيْتُمُوهُ أَمْرَكُمْ، وَأَنَا لَكُمْ وَزِيراً خَيْرٌ لَكُمْ مِنِّي أَمِيراً»(2) .
ولكنّ المسلمين أبوا عليه هذا الرفض، فاستجاب لهم وبويع بالحكم، وقد بدأ (عليه السّلام) بإصلاح الإدارة التي أفسدها عثمان، ونجح في ذلك. وقد قال بهذا الصدد:
____________________
(1) مروج الذهب - المسعودي
(2) نهج البلاغة 1 / 217.
«وَلَكِنَّنِي آسَى أَنْ يَلِيَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ سُفَهَاؤُهَا وَفُجَّارُهَا؛ فَيَتَّخِذُوا مَالَ اللَّهِ دُوَلاً، وَعِبَادَهُ خَوَلاً، وَالصَّالِحِينَ حَرْباً، وَالْفَاسِقِينَ حِزْباً».
وقضى الإمام على الفروق الجاهليّة، وكان مبدؤه بهذا الصدد: «الذليل عندي عزيز حتّى آخذ الحقّ له، والقويّ عندي ضعيف حتّى آخذ الحقّ منه»(1) .
ولم يمضِ بعض الوقت حتّى وضع الإمام علي الاُمور بنصابها وأحقّ الحقّ وقضى على التفاوت الطبقي، ممّا أثار حفيظة قريش فأرسلوا له الوليد بن عقبة بن أبي معيط يفاوضه؛ كي يضع عنهم ما أصابوه من مال أيّام عثمان على أن يبايعوه، ولكنّ الإمام رفض، فبدأت الدسائس والمؤامرات، وكان أوّلها حركة تمرّد في البصرة تحت شعار (الثأر لعثمان)، فقمعها الإمام، وفرّ مَن بقي من أنصارها إلى الشام، حيث قامت حكومة برئاسة معاوية بن أبي سفيان انضوى تحت لوائها كلّ الموتورين الذين ساءهم إصلاح حال الاُمّة الإسلاميّة على يد علي (عليه السّلام).
ولم تدُم الأيّام طويلاً فولدت حركة تمرّد اُخرى تحت شعار (الثأر لعثمان)، وكانت بزعامة معاوية فكانت معركة صفّين وكانت خدعة التحكيم، ثمّ النهروان، ثمّ مقتل علي (عليه السّلام)، ومبايعة ابنه الحسن، واضطراره للتخلّي عن الحكم تحت ضغط الأحداث وتوالي المؤامرات والدسائس.
انتقامُ معاوية من شيعة علي
وصارت الاُمور إلى معاوية وسيطر على الاُمّة الإسلاميّة كلّها، يسوسها
____________________
(1) نهج البلاغة 1 / 218.
بالإرهاب والتجويع، والتخدير باسم الدِّين، والتدجين باسم القبليّة والإمامة. وكان من دهائه وخبثه أن استدعى بسر بن أرطأة وقال له: لا تنزل على بلد أهله على طاعة علي إلاّ بسطت عليهم لسانك حتّى يروا أنّهم لا نجاء لهم، وأنّك محيط بهم، ثمّ اكفف عنهم وادعهم إلى البيعة لي، فمَن أبى فاقتله، واقتل شيعة علي حيث كانوا(1) .
وقد كتب نسخة إلى عمّاله بعد ما سمّاه بعام الجماعة يقول فيها: أن برئت الذمّة ممَّن روى شيئاً من فضل أبي تراب وأهل بيته. فقامت الخطباء فوق كلّ منبر يلعنون علياً ويبرؤون منه، ويقعون فيه وفي أهل بيته.
وقد عالن الناس بطبيعة حكمه بكلمته الشهيرة: يأهل الكوفة أترونني قاتلكم على الصلاة والزكاة والحج؟ وقد علمت أنّكم تصلّون وتزكّون وتحجّون، ولكنّي قاتلتكم لأتأمّر عليكم، وألِيَ رقابكم، وقد آتاني الله ذلك وأنتم كارهون.
وقد سجّل له التاريخ بأنّه نكّل بشيعة علي بعد موت ابنه الحسن أيّما نكال، واستباح دماً كثيراً، فكانت الأعداد في خانة الاُلوف، وكانت وسائله في ذلك زمرة من السفّاحين، مثل زياد وسمرة بن جندب الذي قتل كلّ مَن اتّهم بدم عثمان، وسبى نساء همدان وباعهن في الأسواق مسجّلاً بذلك سابقة خطيرة في بيع نساء المسلمين(2) .
وبلغ من شدّة دهاء معاوية أن جعل الكثيرين يعتقدون بسعة حلمه وكرمه وصبره، وكان ذلك بفعل نشاط (القصّاصين) الذين كانوا يتولّون إذاعة كلّ مليح وحسن عنه مستشهدين بفلان وفلان..
____________________
(1) نهج البلاغة 2 / 6 - 7.
(2) ذكرت بعض المراجع أنّ إرهاب معاوية دفع بالناس لإعلان زندقتهم وكفرهم على أن لا يقال عنهم أنّهم من شيعة علي.
وقد نجح في سياسته بتأليب القبائل على بعضها في الشام والعراق واليمن، وإثارة العصبيّات بينها لتشغل ببعضها عنه، وقد وصف - ولها وزن - هذه السياسة بقوله: وأجّج الولاة نار هذه الخصومة، ولم يكن تحت تصرّف الولاة إلاّ شرطة قليلة، وفيما سوى ذلك كانت فرقهم من مقاتلة المصر، حتّى إذا أحسنوا التصرّف تهيّأ لهم أن يضربوا القبائل بعضها ببعض، وأن يثبتوا مركزهم بينهم(1) .
وكان من نتيجة هذه السياسة أن ظهر الشعر السياسي والحزبي والقبلي، واشتعلت حرب الهجاء والمفاخرات القبليّة الجوفاء، فانضمّ الأخطل إلى الاُمويّين، ضدّ قيس عيلان شاعر التغلبيين، ثمّ انضمّ إلى الفرزدق على جرير لسان القيسيّة على تغلب.
استفحالُ خطر التحريف
وتطوّرت هذه الروح القبليّة وصارت خطراً اتّخذ شكل تأليف الأحاديث ونسبها إلى النبي (صلّى الله عليه وآله).
واستفحلت حال المسلمين، وبدا أنّ الاُمّة في طريقها إلى الانهيار الكامل؛ فقد بدأت ألوان جديدة من التحريف في أحاديث منسوبة إلى الرسول (صلّى الله عليه وآله)(2) مثل: إنّ الله ائتمن على وحيه ثلاثاً: أنا وجبريل ومعاوية.
____________________
(1) الدولة العربية، ولها وزن.
(2) في سلسلة دروس فقهيّة ألقاها المرجع الديني الأعلى الإمام المجاهد السيّد آية الله روح الله الخميني على طلاّب علوم الدين في النجف الأشرف، جاء فيها: إنّ هؤلاء ليسوا بفقهاء، وقسم منهم ألبستهم دوائر الأمن والاستخبارات العمائم لكي يدعوا الله للسلطان، وقد ورد في الحديث في شأن هؤلاء:«فاخشوهم على دينكم».
وإنّ الرسول (صلّى الله عليه وآله) ناول معاوية سهماً وقال له: خذ هذا حتّى تلقاني في الجنّة.
وأنا مدينة العلم، وعليّ بابها، ومعاوية حلقتها.
وتلقون من بعدي اختلافاً وفتنة، فقال له قائل من الناس: فمَن لنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالأمين وأصحابه. والأمين هنا عثمان.
ولتكون سياسة التدجين والإسكات تامّة، فإنّ حديثاً أظهره أحدهم يقول: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إنّكم سترون بعدي أثرة وأموراً تنكرونها، قالوا: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدّوا إليهم حقّهم، وسلوا الله حقّهم. و مَن رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه(1) .
ولكنّ الاُمّة التي اضطُهدت وجُوّعت لم تعد تستطع الحراك وصارت في حالة ما بين وبين، تخاف الجهر بما تعتقده وتخاف التحرّك بوحي من هذا الاعتقاد، ولم يبقَ لها إلاّ السكوت على هذا الضيم؛ لأنّ الكلام معناه القتل والتجويع والتشريد.
ولعلّ خير مَن صوّر هذا الموقف المتذبذب الخائف للحسين كان الفرزدق حين سأله (عليه السّلام) عن أهل الكوفة، حيث أجابه: قلوبهم معك وسيوفهم عليك.
ولم يتأتّ لهذه الاُمّة ولو معشار ما تأتّى للجيل الذي سبقها أيّام عثمان، فقد كانت ردّات فعل الاُمّة آنذاك قويّة استطاعت أن توقف عثمان عند حدّه، ولكن على عهد معاوية أسقط في يد اُمّة الإسلام، فمعاوية كان من الدهاء والغدر والثعلبيّة ما لم يكن لثعمان، وقد نجح في سياسة البطش والإرهاب نجاحاً لم يبلغه سابق ولا لاحق له.
____________________
(1) ذكر البخاري كثيراً من هذه الأحاديث المنسوبة، كما جاء ذكرها في كثير من كتب الأحاديث.
وكان معاوية في بطشه يهدف إلى جعل الحكم خلافة ملك كسروي بعد أن نجحت الأرستقراطيّة الوثنيّة بإقامة دولة كبرى؛ وهذا ما تفسّره عبارته المشهورة: أنا أوّل الملوك(1) .
وهذا معناه أنّ معاوية كان يقصد أنّه أوّل الملوك في الإسلام الوليد الذي لم يعرف الملكيّة بهذا الشكل الرهيب الذي وضع اُسسه كما يحلو له، وكما يرغب في توريثه لمَن بعده.
كلّ ذلك من ألوان الانتهاكات، وتحريف روح الإسلام ومبادئ العقيدة، والعودة إلى النزاعات الجاهليّة التي قام الإسلام ليحاربها، كلّ ذلك كان يتمّ ومعاوية سادر في غيّه يزداد بغياً على بغي، والاُمة الإسلاميّة سادرة في خنوعها وذلّها، وتزداد استسلاماً على استسلام، والحسين (عليه السّلام) يرقب ذلك كلّه، وتهاويل ثوريّة تعتمل في صدره، صابراً على ما آلت إليه اُمّة الإسلام.
وكأنّه (عليه السّلام) ينتظر إتيان ساعة الخلاص ليعطى الإشارة من لدن العناية الإلهيّة للقيام بانتفاضته التي ستعيد عقيدة جدّه إلى صراطها المستقيم الذي أنزلت فوقه، وتعيد إزكاء شعلتها التي خبت في الصدور بفعل التدجين المنظّم باسم الدِّين والإرهاب، وليفتدي بمقتله إحياءها من جديد، وليكمل الشهادات العظيمة التي كتبها الله تعالى على الأنبياء والوصيّين والشهداء الأخيار، فيستمرّ الإسلام ويبقى بشهادته، كما بدأت حين أنزل على جدّه الرسول الأعظم ونشر بتضحياته الكبيرة.
____________________
(1) لقد أبطل الاسلام الملكيّة وولاية العهد، واعتبر في أوائل ظهوره جميع أنظمة السلاطين في إيران ومصر واليمن والروم غير شرعيّة، وكان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قد كتب إلى (هرقل) ملك الروم وإلى ملك فارس يدعوهما إلى الكفّ عن استعباد الناس، ويدعوهما فيها إلى إرسال الناس على سجاياهم ليعبدوا الله وحده؛ لأنّ له السلطان وحده. والحسين قام بثورته التاريخيّة للقضاء على اُسلوب هذه السلطنات المشؤوم - راجع مقدمة خطب الإمام آية الله الخميني (رحمه الله).
الأسباب القريبة للثورة
أ. في عهد معاوية
لطالما تساءل الكثيرون عن السبب الذي حدا بالحسين (عليه السّلام) لتأجيل انتفاضته إلى عهد يزيد، ولِمَ لَم يفجّرها في عهد معاوية ما دامت مفاسده ظاهرة للعيان؟ وما دامت الاُمّة الإسلاميّة قد وصلت إلى درجة التراقي ووصل بها سيل الاضطهاد الزُبى؟
ولكثرة ما طرح هذا التساؤل، ولكثرة الإجابات المتشابهة في كثير من الأحيان، والتي تبعد غالباً عن حقيقة هذا التأجيل، وعن جوهر الهدف منه، فإنّ تبصّراً متأنيّاً واعياً في دوافع هذا التأجيل، التي لا تتبدّى إلاّ بربطها فيما سبقها وتلاها من نتائج، لكفيل بجلاء أجوبة شافية على التساؤلات التي تثار في كلّ مرّة يتطرّق خلالها البحث عن أسباب عدم قيام الحسين بثورته في عهد معاوية.
ولا شكّ في أنّ التساؤل الملحّ، والأجوبة المبتورة ناقصة النضج من شأنها أن تزيد
في تفسير الأمر على نحو بعيد عن الحقيقة الجوهريّة له.
وبرأيي أنّ كلّ مَن ساهم في وضع جواب على تساؤل بهذا الصدد كان يغفل إلى حدّ بعيد دَور العناية الإلهيّة في تسيير خطى الحسين في طريقها الصحيح وفي الوقت المناسب؛ لأنّنا لو نظرنا إلى حركة الحسين بأنّها أمر من الله سبحانه وتعالى سبق وأن تنبّأ بها الأنبياء والوصيّون، فإنّنا لا نعدو الحقيقة لو سلّمنا جدلاً بأنّ موضوع التأجيل كان لحكمة عُلويّة أوحت للحسين بكيفيّتها وتوقيتها حتّى تؤتي ثمارها، وتبلو مضاءها، ولا يكون لها من الثورات التقليديّة إلاّ اسمها فحسب، بينما يختلف مضمونها وجوهرها اختلافاً كلّياً.
لم يكن الشهيد إذاً يفكّر من عنديّاته حينما جاءته كتب أهل العراق تسأله الثورة على معاوية، فأجابهم: «فليس رأيي اليوم ذلك، فالصقوا رحمكم الله بالأرض، واكمنوا في البيوت، واحترسوا من الظنّة ما دام معاوية حيّاً»(1) . ومثل هذا القول أجاب به عيسى (عليه السّلام) على اُمّه حينما دعته لاجتراح اُعجوبة، إذ أجابها: «يا اُمّاه، لم تأتِ ساعتي بعد»(2) .
فلم يقول الحسين هذا القول ما دامت القتلة هي القتلة سواء؛ أكانت على يد معاوية، أم على يد يزيد، وما دام غير قادر على هزيمة أيّ منهما بقوّة عسكريّة.
هنا تتجلّى الحكمة العُلويّة، ومن هذه النقطة بالذات علينا أن نفهم سرّ عدم قيام
____________________
(1) الأخبار الطوال.
(2) يوحنا 1/ 4 - 5
الحسين في عهد معاوية، والسرّ في قيامه بها على هذا الشكل الضعيف عسكرياً في عهد يزيد.
السرّ في عدم قيام الحسين في عهد معاوية يكمن في كلمة (البيعة) التي وصفها (عليه السّلام) بأنّه كان لها كارهاً، وكان من نبل أخلاقه أن رضخ لتصرّف أخيه الحسن الذي قطع العهد مع معاوية، ولم يشأ أن يعطّل رأيه واجتهاداته في هذا الصدد، وكان يجيب مَن يسأله رأيه في عهد أخيه الحسن لمعاوية: «بأنّ لأخيه رأياً في الموادعة، وله هو رأي في جهاد الظلمة، والرأيان رشد وسداد، وأمر لكليهما من الله تعالى ورسوله».
ثمّ يطلب من شيعته بأن يكون كلّ امرئ منهم حلساً(1) من أحلاس بيته ما دام ابن هند حيّاً، فإن يهلك وهم أحياء يرجو أن يخيِّر الله لهم ويأتهم رشدهم، ولا يكلهم إلى أنفسهم.
وفي عبارة «فإن يهلك وأنتم أحياء رجونا أن يخيّر الله لنا» معنى مفسّراً لرأيه عدم الخروج في عهد معاوية، يتجلّى تفسيره أكثر بربطه في الجملة التي تليه: «ويأتنا رشدنا»، ممّا يستدلّ معها على أنّ الله تعالى هو الذي سيمدّه بالأمر، ويؤتيه رشده؛ كي يصبح قادراً على الحركة والقيادة.
ويعطي هذا التفسير - انتظار موت معاوية - تفسيراً آخر بقول الحسين (عليه السّلام): «والصقوا في الأرض، واخفوا الشخص، والتمسوا الهدى» على أنّ فترة الكمون هذه ما هي إلاّ فترة تبصّر بالوحي الإلهي الذي كان الشهيد يأتمر بإمرته، والذي كان يصوّر له وحده هذا الاُسلوب غير المألوف في الثورات، ويمدّه
____________________
(1) حلس بالمكان حلساً: لزمه ولم يغادره.
بالصبر إلى حين تدقّ ساعته، ونفس هذا الوحي الإلهي كان يحجب عن بصائر صحبه الكيفيّة والاُسلوب اللذين سيسبغهما على ثورة الحسين، وهذا ما يفسّره إلحاحهم على الحسين للسير على خطى أخيه الحسن وأبيه في الكفاح المسلّح.
ولكنّ الحسين كان فكره في واد، وفكر صحبه في وادٍ آخر. فهو لو قام بحركته في عهد معاوية بتكتيك عسكري، سبق وإن قام به أبوه وأخوه وآخرون، فإنّه قد ينتصر على معاوية، فيعتبره الناس - بمقياس تفكيرهم في ذلك الزمن - أنّه قائد عسكري نجح في صراع القوّة بما له من عدد وعدّة. ولو هُزم فكان اعتبر أحد الذين نكّل بهم معاوية وألحقهم بحتوف مَن سبقهم، يثير موته الحزن في اُسرته، ثمّ يطويه النسيان كما يطوي أيّ ثائر تقليدي.
ثمّ إنّ الحكمة العُلويّة تلعب دورها الأكيد في عدم مناجزة الحسين لمعاوية، إذ كان معاوية من صنف اُولئك الحكّام الذين كان الشعب ينظر إليهم نظرة احترام خاصّة ممزوجة بالحقد المقيت عليهم، وما كان مستبعداً، وقد عرفنا ما عليه جُبِلَ معاوية من دهاء وثعلبيّة، أن يلصق بالحسين تهماً باطلة بواسطة المرجئة وقصّاصيه النشطين، فتؤدّي حركته إلى نتيجة عكسيّة من حيث كانت تقصد العكس.
وقد أوصى الحسين صحبه باللصوق بالأرض وإخفاء شخوصهم، وهذا التكتّم وهذه التقيّة كانت لسرّ آخر، فالحسين كان قد عاصر حروب الجمل وصفّين والنهروان، وخَبُر دسائس معاوية وقدرته على اختراق ستار الكتمان ليصل إلى خصومه بكلّ الطرق، وأشهرها السمّ الذي قتل به أخاه الحسن(1) ، والذي كان فريداً لوحده بأساليب استخدامه، وبإطلاقه تلك التسمية العجيبة عليه
____________________
(1) ذكر أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيّين: لمّا أراد معاوية البيعة لابنه يزيد لم يكن شيء أثقل عليه من أمر الحسن وسعد بن أبي وقّاص، فدسّ إليهما سمّاً، فماتا منه).
بقوله: إنّ لله جنوداً منها العسل(1) ؛ لذا جاءت تقيّته لتؤدّي غرضاً آخر من أغراض صبره، ولم تَكُ هذه التقيّة نتيجة لخوف من معاوية أو أساليبه - وهذا ما برهن عنه الحسين خلال مواقفه - بل كان نتيجة خوف الشهيد من أن يقضي عليه معاوية قبل أن يحين أجل قيامه بثورته التي ستختلف كليّاً عمّا سبقها من ثورات وحروب، والتي ستنحو منحى جديداً أمضى بكثير من المنحى العسكري، والتي بها سيتحقّق الوعد الإلهي بإعادة الدِّين الإسلامي إلى أشكال بدايته السليمة.
وللذين لا يقيمون أدنى دور لهذا الوعد من الأجدر لهم أن يعيدوا قراءة وتمعّن كلّ الأحداث التي مرّ بها الإسلام الوليد منذ أن اُنزل على خاتم الرسل والأنبياء محمّد (صلّى الله عليه وآله)، وكيف هدى هذا الوعد الرسول الكريم لتوقيع صلح الحديبيّة مع مشركي مكّة، ومحوه من العقد كلمة (بسم الله الرحمن الرحيم) و (محمّد رسول الله)، وكيف رضي علي (عليه السّلام) بالتحكيم بعد خدعة المصاحف في صفّين؟ وكيف صالح أخوه الحسن معاوية الذي اغتصب الخلافة وحرّف الدين؟
وهذا السرّ الإلهي الذي لا يستطيع تفسير كوامنه إلاّ المبصرون لا يهتمّ كثيراً للظروف الوقتيّة أو الطارئة إذا كان فيها منجى للعقيدة مؤقتّاً، أو فيها استعداد لقفزة ثانية لهذه العقيدة؛ ولذا فإنّ اللّبس يخيّم على عقول كثيرة، وتكون الدهشة والاستنكار هما الثمن لعدم فَهم هذه العقول لحكمة السرّ الإلهي في إظهار بعض الاُمور بمظهر عكسي.
وثمّة عامل آخر، وإن كان أقلّ أهميّة من العامل الذي سبقه، وهو أنّ مجتمع العراق الذي أنهكته الحروب وفتّت في عضده الخسائر والهزائم لم يكن مستعدّاً
____________________
(1) عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) 1 / 201.
لأدنى مناجزة يشهرها في وجه معاوية بالذات.
وعامل آخر يضاف إلى جملة العوامل الثانويّة: وهو أنّ قيام الحسين في عهد معاوية قد يكون مبرّراً لمعاوية لكي يصوّره بصورة المستغلّ الناقض لعهده وميثاقه، والحسين لا يسعى إلى هذه الصورة وإن كانت من باب التجنّي الواضح عليه، وهو ما كان يربأ أن يعرف به؛ لأنّه في جوهره بعيد عن الاستغلال ونقض العهود.
كان (عليه السّلام) يحسب لكلّ أمر حسابه في ميزان النتيجة، أمّا الهدف الذي كان يرنو إليه في سكوته على زمن معاوية فهو في تعبئة نفوس أهل العراق خاصّة، والمسلمين عامّة على مخازي اُميّة، وبذلك يكسب مزيداً من الوقت لنجاح هذه التعبئة النفسيّة، حتّى إذا ما قام بحركته التي هي في جوهرها - حرب نفسيّة وروحيّة - أكثر منها حرباً عسكريّة، يكون قد وجد أرضاً ممهّدة لها، وضَمن نتائج إيجابيّة لأهدافها(1) .
ثمّ وهو الذي خَبُر معاوية كان ينتظر موته كي يتولّى يزيد الخلافة، فيفضح بتهوّره وعدم حرصه كلّ المخازي التي ارتكبها ويرتكبها الاُمويّون باسم الخلافة، إذ كان معاوية اُستاذاً لا يبارى في إخفاء حقيقته، وكان كتوماً حريصاً على الظهور بعكس خبيئته، حتّى أنّه أفلح في خداع أكثر الناس تبصّراً وملاحظة(2) .
ورجل هذا شأنه، سيعرف الحسين بأنّه من قبيل المغامرة القيام على عهده، فهو لن يفلح معه عسكريّاً وليست له أساليبه في الخداع
____________________
(1) يقول (ماربين) الألماني: إنّ الحسين كان يبثّ روح الثورة في المراكز الإسلاميّة المهمّة كمكّة والعراق وأينما حلّ. فازدادت نفرة قلوب المسلمين التي هي مقدّمة الثورة على بني اُميّة.
(2) نفسه: الحسين بمبلغ علمه وحُسن سياسته بذل كمال جهده في إفشاء ظلم بني اُميّة وإظهار عداوتهم لبني هاشم.
والتحايل. ففضّل (عليه السّلام) الانتظار والصبر على مكارهه على أن يقدم على خطوة ليس لها نتائج، أو قد تؤدّي إلى نتائج عكسيّة حيث كان يرغب العكس.
وإذا كان الحسين قد فضّل التريّث والانتظار حتّى يقضي الله أمراً كان مفعولاً، فإنّ التزامه بالعهد الذي قطعه أخوه الحسن كان التزاماً صحيحاً لا مفتعلاً في ظاهره؛ إذ لو كان راغباً في التنصّل من هذا الالتزام فما كان أسهله عليه لو تحجّج بأنّه لم يُسهم به ولم يكن راضياً عنه، فيتجنّب الملامة.
ويدعم رأينا هذا بأنّ الحسين (عليه السّلام) كان ملتزماً فعلاً لا قولاً بموقفه من البيعة بعد موت أخيه، وذَكَره للذين كتبوا له من شيعته بالعراق بأنّه ملتزم بالعقد مع معاوية، ولا يجوز له نقضه حتّى تمضي المدّة ويموت معاوية، وكأنّه يقول لهم: وبعد ذلك لكلّ حادث حديث.
وصحّ حدس الحسين (عليه السّلام)، فها هو معاوية يلجأ أكثر من مرّة لاستباق الزمن، واستغلال حرمة العهد في نفوس المسلمين ونفسه بالذات، فيلوّح بها في أحد كتبه له، مشيراً إلى نشاطه في تعبئة المجتمع الإسلامي على الحكم الاُموي، وكأنّه يخشى من قيامه بنقض هذا العهد وفضحه.
وقد كتب إليه قائلاً: أمّا بعد، فقد انتهت إليّ اُمور عنك، إن كانت حقّاً فإنّي أرغب بك عنها، ولعمر الله إنّ مَن أعطى عهد الله وميثاقه لجدير بالوفاء! وإنّ أحقّ الناس بالوفاء مَن كان مثلك في خطرك وشرفك ومنزلتك التي أنزلك الله بها، ونفسك فاذكر، وبعهد الله أوف، فإنّك متى تنكرني أنكرك، ومتى تكدني أكدك، فاتّق شقّ عصا هذه الاُمّة(1) .
____________________
(1) الإرشاد - الشيخ المفيد / 206، إعلام الورى / 20، وتاريخ الخلفاء - السيوطي/ 206.
ولنلاحظ في كتاب معاوية الرغبة في استباق الزمن، والاحتراس مسبقاً من نقض العهد من قِبَل الحسين؛ لذا فقد أسرع بالكتابة إليه، حتّى إذا ما نقض العهد كان كتابه وثيقة تبرّر بطشه به أمام المسلمين، الذين تثيرهم قضيّة العهد والثبات على الميثاق، فيكون بذلك قد أسقط في يده سلفاً، وأسقط الكرة في مرماه.
وفي كتاب آخر أرسله إليه يقول بلهجة مهدّدة: وقد اُنبئت أنّ قوماً من أهل الكوفة قد دعوك إلى الشقاق، وأهل العراق ممَّن قد جرّبت، قد أفسدوا على أبيك وأخيك، فاتّقِ الله، واذكر الميثاق(1) . في هذَين الكتابَين نلمح نقرأ مكثّفاً على وتر الميثاق، (إنّ مَن أعطى عهد الله وميثاقه لجدير بالوفاء) و (اتّق الله واذكر الميثاق) و (ونفسك فاذكر وبعهد الله أوف).
وعلى الرغم من هذا التكتيك المقصود به تسجيل سابقة على الحسين فيما لو فكّر بنقض العهد، فإنّ الحسين كان قد بدأ بردّ هذه الحرب النفسيّة في سلسلة كتب لمعاوية ضمّنها كلّ الشكوك والريبة التي كانت تعتمل في نفوس المسلمين وضمائرهم حيال ممارساته للسلطة، وكانت هذه الكتب (الردود) إيذاناً ببدء التمهيد للثورة باُسلوب نفساني.
كان يقصد منها الحسين تعبئة النفوس بشكل نهائي، وتفجير الخلاف بينه وبين معاوية؛ كي لا يلام على أمرين، اُولاهما: على نقضه للميثاق، وثانيهما: على السكوت أمام المباذل والانتهاكات التي كان يأتيها الخليفة المزعوم دون أن يرفع إصبع أمامه بالنقد.
بدأ الحسين بهذه الحرب بعد أن نمي إليه عزم معاوية على التمهيد للبيعة ليزيد،
____________________
(1) ذكر فيليب حتّي في (تاريخ العرب) 2 / 252 أنّ أهل الكوفة كانوا قد بايعوا الحسين بعد موت أخيه، بينما الواقعة الصحيحة تشير إلى عدم استجابة الحسين لهذه المبايعة.
وبعد أن ورده كتابه بشأن الميثاق وذكره لِما نمي إليه في الشام بشأن قوم الكوفة الذين أنبؤوه بتحرّك شيعته في العراق، وما كان من أمره معهم حينما دعاهم للتريّث والالتصاق بالأرض.
ولعلّ كتاب (الردّ) الذي بعث به الحسين لمعاوية يعتبر وثيقة تاريخيّة دامغة على عهد معاوية، ومن الإغماط لها أن نختصرها أو نتحدّث عنها بصيغة الغائب في كتابنا هذا، إذ إنّها صورة وافية موضّحة لشخصيّة معاوية وحُكمه كما رآهما وعاصرهما الحسين (عليه السّلام)، ومن المناسب تثبيتها في هذا المتن ليطّلع عليها كلّ من يتوفّر على قراءة هذا الكتاب.
فمهما جهد المحلّلون والمؤرّخون في البحث عن مثالب معاوية فإنّهم لن يجمعوا معشار ما ثبّته الحسين في كتابه هذا. ومن جهة اُخرى فإنّ الكتاب يوضّح تماماً موقف مرسله من قضايا الحكم والانتهاكات التي يمارسها معاوية، ويكشف في الوقت ذاته عن مدى نسبة تعاظم الخلاف بينهما في اُخريات أيّام معاوية، قبل البيعة ليزيد بقليل، وكيف كان موقف الحسين من هذه المسألة.
وفي الكتاب تفسير بيّن لسياسة التكتّم والصبر والانتظار التي كان يمارسها الحسين غير هيّاب ولا وجل، والتي كان على استعداد لتحويلها في أيّة لحظة إلى نقيضتها في الجهر والإقدام على النقد، والإشارة بالاتّهام المباشر، البعيد عن التقيّة التي دعا إليها. وفي هذا مَثَل واضح على أصالة موقف الحسين، وعلى عمق مبادئه القادرة على احتواء كافّة الأبعاد، وهضم كافّة المتناقضات، لتبدو أخيراً بالشكل الذي يبتغيه لها صاحبها.
كتب الحسين (عليه السّلام) لمعاوية يقول له في جرأة نادرة(1) : «أمّا بعد، فقد بلغني كتابك تذكر فيه أنّه انتهت عنّي اُمور أنت لي عنها راغب،
____________________
(1) راجع الإمامة والسياسة - لابن قتيبة 1 / 284، وأخبار الرجال - لأبي عمرو الكشي، واختيار الرجال - لأبي جعفر الطوسي / 32.
وأنا بغيرها عندك جدير، وأنّ الحسنات لا يهدي لها ولا يسدّد إليها إلاّ الله تعالى.
أمّا ما ذكرت أنّه رقي إليك عنّي، فإنّه إنّما رقاه إليك الملاّقون والمشّاؤون بالنميمة، المفرّقون بين الجمع، وكذب الغاوون؛ ما أردت لك حرباً ولا عليك خلافاً، وإنّي لأخشى الله في ترك ذلك منك، ومن الأعذار فيه إليك وإلى أوليائك القاسطين حزب الظلمة.
ألستَ القاتل حِجر بن عدي أخا كندة وأصحابه المصلّين العابدين الذين كانوا ينكرون الظلم، ويستفظعون البدع، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولا يخافون في الله لومة لائم، ثمّ قتلتهم ظلماً وعدواناً من بعد ما أعطيتهم الأيمان المغلّظة والمواثيق المؤكّدة؛ جرأة على الله واستخفافاً بعهده؟!
أولست قاتل عمرو بن الحمق صاحب رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، العبد الصالح الذي أبلته العبادة فنحل جسمه واصفرّ لونه، فقتلتَه بعدما أمّنته وأعطيته من العهود ما لو فهمته العصم لنزلت من رؤوس الجبال؟!
أولستَ بمدّعي زياد ابن سميّة المولود على فراش عبيد ثقيف، فزعمت أنّه ابن أبيك، وقد قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): الولد للفراش وللعاهر الحجر. فتركت سنّة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) تعمّداً، وتبعت هواك بغير هدىً من الله، ثمّ سلّطته على أهل الإسلام يقتلهم ويقطع أيديهم وأرجلهم، ويسمل أعينهم، ويصلبهم على جذوع النخل، كأنّك لست من هذه الاُمّة وليسوا منك؟!
أولستَ قاتل الحضرمي الذي كتب فيه زياد إليك أنّه على دين علي (عليه السّلام)، فكتبت إليه: أن اقتل كلّ مَن كان على دين عليٍّ. فقتلهم ومثّل بهم بأمرك، ودينُ عليٍّ هو دين ابن عمّه (صلّى الله عليه وآله) الذي أجلسك مجلسك الذي أنت فيه، ولولا ذلك لكان شرفك وشرف آبائك تجشّم الرحلتين؛ رحلة الشتاء والصيف؟!
وقلتَ فيما قلتَ: انظر لنفسك ولدينك ولاُمّة محمّد، واتّق شقّ عصا هذه الاُمّة وأن تردهم إلى فتنة. وإنّي لا أعلم فتنة أعظم على هذه الاُمّة من ولايتك عليها، ولا أعظم نظراً لنفسي ولديني ولاُمّة محمّد (صلّى الله عليه وآله) أفضل من أن اُجاهدك؛ فإن فعلت فإنّه قربة إلى الله، وإن تركته فإنّي أستغفر الله لديني وأسأله توفيقه لإرشاد أمري.
وقلتَ فيما قلت: إنّي إن أنكرتك تنكرني، وإن أكدك تكدني. فكدني ما بدا لك، فإنّي أرجو أن لا يضرّني كيدك، وأن لا يكون على أحد أضرّ منه على نفسك؛ لأنّك قد ركبتَ جهلك، وتحرّصت على نقض عهدك. ولَعمري ما وفيتَ بشرط، ولقد نقضتَ عهدك بقتل هؤلاء النفر الذين قتلتهم بعد الصلح والأيمان، والعهود والمواثيق، فقتلتهم من غير أن يكونوا قاتلوا أو قُتلوا، ولم تفعل ذلك بهم إلاّ لذكرهم فضلنا وتعظيمهم حقّنا؛ مخافة أمر لعلّك لو لم تقتلهم متّ قبل أن يفعلوا، أو ماتوا قبل أن يدركوا.
فأبشر يا معاوية بالقصاص واستيقن بالحساب(1) ، واعلم أنّ لله تعالى كتاباً لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلاّ أحصاها، وليس الله بناسِ لأخذك بالظنّة وقتلك أولياءه على التّهم، ونفيك إيّاهم من دورهم إلى دار الغربة، وأخذك للناس ببيعة ابنك الغلام الحدث، يشرب الشراب ويلعب بالكلاب، ما أراك إلاّ قد خسرت نفسك، وتبّرت دينك، وغششت رعيّتك، وسمعت مقالة السّفيه الجاهل، وأخَفْتَ الورع التّقي، والسّلام».
والمتمعّن في هذا الكتاب لا بدّ وأن يلاحظ رغبة الإمام الحسين (عليه السّلام) في فضح معاوية وردّ سهامه إلى صدره. فمعاوية يتّهمه بشقّ عصا اُمّة الإسلام،
____________________
(1)( إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنْ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ) (سورة آل عمران / 21).
فيجيبه: «إنّي لا أعلم فتنة أعظم على هذه الاُمّة من ولايتك عليها»(1) . ويهدّده بقوله: اتّق الله واذكر الميثاق، فيجيبه (عليه السّلام): «لقد نقضت عهدك بقتل ذاكري فضلنا بعد الصلح والأيمان، والعهود والمواثيق». ويلوّح له قائلاً: ونفسك فاذكر وبعهد الله أوفِ. فيجيبه «ولا أعظم نظراً لنفسي ولديني ولاُمّة محمّد (صلّى الله عليه وآله) أفضل من أن اُجاهدك، فإن فعلت فإنّه قربة إلى الله»(2) .
وحيال تهديده له، يجيبه (عليه السّلام): «كدني ما بدا لك»(3) . وفي إجابته هذه تحدٍّ نهائي وواضح، أتبعها بعبارة اُخرى أشدّ جرأة: «فابشر يا معاوية بالقصاص واستيقن بالحساب»، فحدّد (عليه السّلام) لخصمه نهاية مظالمه وكيده لاُمّة الإسلام، كما ستكون عليه في مقبل الأيّام.
وكي نفهم معاوية من خلال ردّة فعله حيال كتاب الحسين فإنّنا نراه وقد ركن إلى السكوت بعد ورود هذا الكتاب عليه، ولم يسجّل التاريخ حادثة تنمّ عن غضبه مما جاء فيه. وفي هذا إثبات أكيد على خبثه ودهائه، فلو جاء هذا الكتاب ليزيد بدلاً منه لَما توانى عن شنّ حرب جنونيّة على الحسين(4) .
وفي عبارة الحسين (عليه السّلام) «فكدني ما بدا لك» إحراج لمعاوية، كان يعني بها (عليه السّلام) وضع خصمه حيال اتّهاماته له، فلم يقُل له كدني بما تريد، بل بما بدا لك منّي، أي أنّ ما بدا منه (عليه السّلام) حتّى مجيء كتاب معاوية له، لا يعدو كونه خيالات
____________________
(1)( وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنْ الْقَتْلِ ) (سورة البقرة / 191).
(2) يقول أمير المؤمنين علي (عليه السّلام): «وإنّما عاب الله ذلك عليهم؛ لأنّهم كانوا يرون من الظلمة الذين بين أظهرهم المنكر والفساد فلا ينهونهم عن ذلك؛ رغبةً فيما كانوا ينالون منهم، ورهبةً ممّا يحذرون».
(3) يعيب الله تعالى على المفرطين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفاً وطمعاً حيث يقول عزّته:( فَلاَ تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي ) .
(4) ثمّة تحليل وافٍ ووصفٍ واسع لشخصيّة يزيد في كتاب البلاذري (أنساب الأشراف) 4 القسم الثاني / أ.
وأوهام أو رغبة في استباق الاُمور وتسجيل مواقف سلفيّة عليه؛ بقصد استغلالها ضدّه فيما بعد، فلو قام يكيد له بما بدا له منه فلن يجد ممسكاً واحداً يكيد له به.
وهذه ألمعيّة نادرة من غذيّ الفصاحة الطالبيّة، تفوّقت بصدقها وعفويّتها بمراحل خبث معاوية ودهائه، استطاع (عليه السّلام) بها أن يردّ له الكرة التي قذفه بها، ويكيل له أضعاف ما كال به إليه، وبالتالي إسكاته إلى حين.
وثمّة حقيقة واضحة لمسها المسلمون في كلّ مرّة حاول معاوية فيها الكيد للحسين واتّهامه بما لا يفعله، وهي أنّ الحسين (عليه السّلام) رغم كلّ ما اُوذي به من معاوية وما ناله من ثعلبيّته لم يستبِح لنفسه الخروج عليه، وفاء صادقاً بعهده، على الرغم من جواز خروجه بعد خروج معاوية على كلّ العهود والمواثيق بالشكل الذي اتّهمه فيه من خلال كتابه (الردّ).
ولم تَكُ خلّة الوفاء بالعهد هي خلّة الحسين الوحيدة، بل كانت البارزة في حيّز صراعه النفسي مع معاوية، وليس أدلّ من تعاظم شأن هذه الخلّة المحمودة في نفس الحسين من أنّه وقد اتّهم معاوية بقتله لمَن كان على دين أبيه علي (عليه السّلام)، والتمثيل بهم لا لشيء إلاّ لذكرهم فضل بني هاشم وتعظيمهم حقّهم، فإنّه لم يتحرّك ليزاحمه مجلسه الذي أجلسه فيه دين علي الذي هو دين ابن عمّه الرسول (صلّى الله عليه وآله)، والذي لولاه - كما ذكر له في كتابه - لكان شرفه وشرف آبائه، تجشّم الرحلتين.
ولو نادى الحسين بخلع معاوية آنذاك لتنادى له الكثيرون بنفس مناداته، إذ كان معاوية معروفاً بنقضه للمواثيق واستخفافه بعهد الله، وقتله للحسن وحِجر بن عدي والحضرمي وللكثيرين ممَّن يفوقون الحصر. ولكنّ الإمام الذي كانت تعدّه العناية الإلهيّة للشهادة العظمى اكتفى بأن جاهر خصمه بما ينفي عنه كلّ صفة إسلاميّة أو قوميّة بقوله: «كأنّك لست من هذه الاُمّة وليسوا منك».
وتكرّ الأيّام، والحسين ومعاوية على سكوتهما إلاّ من بضعة كتب كانت تتطاير
بينهما بين الفينة والاُخرى، وقد حاول معاوية شراء أو ضمانة سكوت الحسين عن يزيد فلم يفلح، وحاول استمالته بجسّ نبضه حينما أخذ بتولية ابنه يزيد، ولكنّ الحسين الذي كان ينتظر موت الأب ليخرج على الابن أجابه في أحد كتبه إليه(1) : «وفهمت ما ذكرت عن يزيد من اكتماله وسياسته لاُمّة محمّد، تريد أن توهم الناس في يزيد، كأنّك تصف محجوباً أو تنعت غائباً، أو تخبر عمّا كان ممّا احتويته بعلم خاص. وقد دلّ يزيد من نفسه على موضع رأيه، فخذ ليزيد فيما أخذ فيه من استقرائه الكلاب المهارشة عند التهارش، والحمام السبق لأترابهن، والقيان ذوات المعازف وضرب الملاهي، تجده باصراً، ودع عنك ما تحاول؛ فما أغناك أن تلقى الله من وزر هذا الخلق بأكثر ممّا أنت لاقيه. فوالله ما برحت تقدح باطلاً في جور، وحنقاً في ظلم، حتّى ملأت الأسقية، وما بينك وبين الموت إلاّ غمضة».
ولمّا يئس معاوية من حمل الحسين على البيعة لابنه يزيد، عمد إلى حرمان بني هاشم من أعطياتهم؛ حتّى يجبره على البيعة.
ولكنّ الكِبَر والمرض فتّ في عضده، ولم يفتّ في طموحاته، ولم يخفّف من غلواء خبثه. فها هو على فراش النزع الأخير يلجأ إلى أحابيله، ويعمد إلى تمثيليّاته فيأمر أُجَراءه كي يحشوا عينيه إثمداً، ويوسعوا رأسه دهناً، ويوسعوا له كي يجلس، ثمّ يأمرهم بإسناده والإيذان للناس ليسلّموا عليه قياماً دون السماح لهم بالجلوس..
وهكذا رآه الناس مكتحلاً مدهّناً، فعجبوا من الشائعات التي تناقلت خبر مرضه، وما كادوا يخرجون من لدنه حتّى أنشد يقول:
____________________
(1) الإمامة والسياسة 1 / 195 - 196.
وتجلّدي للشامتينَ أريهُمُ |
أنّي لريبِ الدهرِ لا أتضعضعُ |
|
وإذا المنيّةُ أنشبتْ أظفارَها |
ألفيتَ كلَّ تميمةٍ لا تنفعُ |
وأخيراً أرسل إلى مروان عامله على المدينة كتاباً قرأه على الملأ وقال فيه: إنّ أمير المؤمنين قد كبر سنّه ودقّ عظمه، وقد خاف أن يأتيه أمر الله تعالى فيدع الناس كالغنم لا راعي لها، وقد أحبّ أن يعلم علماً ويقيم إماماً.
ولمـّا وافقه الناس كتب بذلك إلى معاوية، فأجابه معاوية: أن سمّ يزيد. فسمّاه لهم. فقام عبد الرحمن بن أبي بكر وقال له: كذبت والله يا مروان وكذب معاوية معك، لا يكون ذلك، لا تجعلوها هرقلية وتحدِثوا علينا سنّة الروم كلّما مات هرقل قام مكانه هرقل(1) .
وأنكر الحسين أيضاً وتبعه عبد الله بن الزبير، ولكنّ معاوية لم يهتمّ وكتب إلى عمّاله أن يمهّدوا البيعة ليزيد في الأمصار، ويرسلوا الوفود إليه في الشام لإعلان بيعتهم.
ولكنّ المدينة لم تبايع كما بايعت الشام والعراق، فقَدِم معاوية إلى المدينة، حيث استقبله أهلها وعلى رأسهم الثلاثة الذين أنكروا على يزيد البيعة، فسبّهم. ولمّا أقام بالمدينة وكان وقت الحجّ خرج حاجّاً، فقَدِموا إليه ثانيةً وقد ظنّوا أنّه تغيّر.. فأكرم وفادتهم وطلب لكلّ منهم دابّة، ثمّ طلبهم فدخلوا عليه حيث دعاهم إلى بيعة يزيد، فقال ابن الزبير: اختر منّا خصلة من ثلاث.
____________________
(1) راجع النوادر - لأبي علي القالي / 175- 176.
قال معاوية: إن في ثلاث لمخرجاً. قال: إمّا أن تفعل كما فعل رسول الله (صلّى الله عليه وآله). قال: ماذا فعل؟ قال: لم يستخلف أحداً. قال: وماذا؟ قال: أو تفعل كما فعل أبو بكر؛ فإنّه عهد إلى رجل من قاصية قريش ليس من بني أبيه فاستخلفه. أو افعل كما فعل عمر بن الخطاب؛ إذ جعلها شورى في ستّة من قريش ليس فيهم أحد من ولده ولا من بني أبيه.
قال: ليس فيكم مثل أبي بكر وأخاف الاختلاف، هل عندك غير هذا؟ قال: لا. قال: ألا تسمعون، إنّي قد عوّدتكم على نفسي عادة وإنّي أكره أن أمنعكموها قبل أن أبيّن لكم، إن كنت لا أزال أتكلّم بالكلام فتعترضون عليّ فيه وتردّون، وإنّي قائم فقائل مقالة، فإيّاكم أن تعترضوا حتّى أُتمّها، فإن صدقتُ فعليّ صدقي، وإن كذبتُ فعليّ كذبي، والله لا ينطق أحد منكم في مقالتي إلاّ ضربت عنقه.
ثمّ وكلّ بكلّ رجل من القوم رجلين يحفظانه لئلاّ يتكلّم، وقام خطيباً فقال: إنّ عبد الله بن الزبير والحسين بن علي وعبد الرحمن بن أبي بكر قد بايَعوا، فبايِعوا.
فانجفل الناس عليه يبايعونه، حتّى إذا اطمأنّ إلى أخذ البيعة ركب رواحله وقفل عائداً إلى الشام. فأقبل الناس على الحسين وصاحبيه يلومونهم دهشين! فقالوا لهم: والله ما بايعنا، ولكن فعل بنا وفعل. فقالوا: وما منعكم أن تردّوا على الرجل برفض البيعة بعد أن زعمتم لنا بأنّكم لا تبايعون؟ قالوا: كادنا وخفنا القتل.
وهكذا تمّت البيعة ليزيد إغفالاً وقسراً وخداعاً. ولم يطل المرض بمعاوية بعد هذه الحادثة إلاّ قليلاً، فلمّا اشتدّ عليه وقرب به من حافة النزع الأخير ألقى لمَن حوله بآخر تلفيقاته، التي لكثرة ما ردّدها صار يصدّقها هو نفسه كما لو أنّها وقعت حقّاً، فقال: إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كساني قميصاً فرفعته، وقلّم أظفاري يوماً فأخذت قلامته، فجعلتها في قارورة، فإذا متّ فألبسوني ذلك القميص، وقطّعوا تلك القلامة، واسحقوها وذرُّوها في عينيَّ وفي فيَّ، فعسى الله يرحمني ببركتها، ثمّ تمثّل ببيتين من الشعر(1) :
إذا متُّ مات الجودُ وانقطع الندى |
من الناسِ إلاّ من قليلٍ مصرّدِ |
____________________
(1) من قصيدة للأشهب بن رملة.
وردّتْ أكفّ السائلين وأمسكوا |
من الدِّين والدنيا بخُلفٍ مُجدّدِ |
ولمـّا اعترضت إحدى بناته أكمل متمثّلاً:
وإذا المنيّةُ أنشبت أظفارَها |
ألفيتَ كلَّ تميمةٍ لا تنفعُ |
ثمّ راح بإغماءة أفاق منها للحظات، فتفوّه بهذه العبارة: اتّقوا الله عزّ وجلّ، فإنّ الله سبحانه يقي مَن اتّقاه، ولا واقي لمَن لا يتّقي الله. وما لبث إلاّ قليلاً حتّى قضى. وكان ذلك في الشهر السابع من سنة 60 للهجرة.
وبموته انقضت مرحلة مشبعة بالدسائس والمؤامرات، لوّنها بدهائه وثعلبيّته، وأنهاها حتّى الرمق الأخير بالكذب على الله ورسوله واُمّة الإسلام، واستعدّت الولايات الإسلاميّة لاستقبال عهد جديد، كانت بوادره تلوح في سماء الاُمّة، فتدفع بالغصص إلى أشدّ الحلوق تفاؤلاً، فيزيد ليس إلاّ معاوية ناقصاً بعض خصاله زائداً بعض خصال أبشع(1) .
واستعدّ الحسين (عليه السّلام) فقد دقّت الساعة وآن الأوان.
____________________
(1) عُلم عن يزيد بأنّه كان مُرسل العنان في بني كلب أخواله، مطيّته الشباب والفراغ والجده، وكان سلوكه متجاوزاً بمراحل ما جاء في الأخبار. وكانت له هوايات شاذّة عجيبة؛ كاللعب بالكلاب، والتصيّد بالفهود، والتلهّي بالقرود.
ذكر ذلك كلّ من المسعودي في مروج الذهب، وأحمد بن يوسف القرماني في أخبار الدول، والدميري في الكلام على الفهد، وابن الطقطقي في الفخري.
ب. في عهد يزيد
لئنْ جرتْ لفظةُ التوحيدِ في فمِهِ |
فسيفهُ بسوى التوحيدِ ما فتكا |
|
قد أصبح الدينُ منه يشتكي سقماً |
وما إلى أحدٍ غير الحسينِ شكا |
هذا ما وصف به أحد الشعراء عهد يزيد، الذي استقبله المسلمون بقلوبٍ واجفة وبأعصابٍ مشدودة. فلا موت معاوية أشعرهم بالحزن، ولا تولّي يزيد أشعرهم بالفرح، وصار حالهم كحال مَن عناهم أحد الشعراء بقوله:
الحمدُ لله لا صبرٌ ولا جلبٌ |
ولا عزاءٌ إذا أهلُ البلا رقدوا |
|
خليفةٌ مات لم يحزنْ لهأحدْ |
وآخرٌ قام لم يفرحْ بهِ أحدُ (1) |
____________________
(1) هذه الأبيات للشاعر دعبل بن علي الخزاعي، وقد قالها لمّا جاءه نعي المعتصم وقيام الواثق. وقد أثبتناها هنا للاستدلال والمطابقة.
إلاّ أنّ مشاعر المسلمين بعد موت معاوية وتولّي ابنه يزيد لم تقف عند حدود عدم الحزن أو الفرح، بل تعدّتها إلى شعور الخوف والترقّب من عهد يزيد الذي لم يعرفوا له لوناً بعد. إذ كان معاوية قد استطاع أن يقيم توازناً ذكيّاً بين ما كان عليه وما ظهر منه للاُمّة، وكان التكتّم هو وسيلته الناجعة في إحداث هذا التوازن، فقنع الناس بهذا الحدّ من الإرهاب والتنكيل ولم يعودوا يجرؤون على الجهر بأكثر من الصمت.
وكانت هذه الخشية التي جاشت في قلوب المسلمين من عهد جديد بدأ ولم تتحدّد أبعاده بعد، نابعة من معرفتهم لشخصيّة يزيد كما سمعوا عنها، ورأوا ما رأوه منها.
فيزيد كان مثالاً لابن السلطان المدلّل المنحرف، وكان كما تروي الكتب عنه أحمق مغروراً، زاده التهوّر سطحية في التفكير، وبُعداً عن الحيطة والتكتّم، وكان اُسلوبه في التصرّف ومعالجة الاُمور اُسلوب مَن يركب كلّ مركب ومطيّة دون النظر في عواقب فعلته.
وكان على النقيض من أبيه معاوية، فكلّ التكتّم عند معاوية كان يقابله عند يزيد المجاهرة والانفلاش، وكلّ تكتيك عند أبيه كان يقابله عنده تهوّر واضح واندفاعة هوجاء.
وهذه الشخصيّة في مقياس علم النفس تسمّى بالشخصيّة (العصابيّة) وخصائصها هي ذات الخصائص التي عُرف بها يزيد، ومن مزاياها الاستجابة الفوريّة والسريعة والعنيفة لردود الفعل، وخفّة الشخصيّة وسرعتها في الانقياد للآراء الجديدة، سواء أكانت صائبة أم خائبة، وصاحب هذه الشخصيّة إنسان فتّاك يغدر بأقرب المقرّبين إليه، ولا يتورّع عن ركوب أشنع الأساليب للوصول إلى غرضه.
ويصفه (سيجموند فرويد): بأنّ صاحب الشخصيّة العصابيّة إنسان ذو فائدة لعدد من الناس الأذكياء، يدغدغون عصبيّته ويبتزّون منه الفوائد(1) .
وهذا الوصف كان ينطبق إلى حدٍّ بعيد على شخصيّة يزيد. إذ كان القرّادون والفهّادون والقيان والقوادّون وسمسارو الجواري والعاهرات يشكّلون طبقة عريضة مستفيدة من أعطياته التي كان يحجبها عن المحتاجين من اُمّته، ويغدقها عليهم طالما هم يمتّعونه ويؤمّنون له الاستمراريّة في مباذله ومجونه.
كان موفَر الرغبة في اللهو والقنص والخمر والنساء وكلاب الصيد، حتّى كان يُلبسها الأساور من الذهب والجلال المنسوجة فيه ويَهَب لكلّ كلب عبداً يخدمه. وساس الدولة سياسة مشتقّة من شهوات نفسه(2) .
ورجل هذه صفاته كان من غير الممكن أن يسكت عن معايبه رجل كالحسين (عليه السّلام) عُرف بالتقوى وخوف الله والبذل للمحتاجين، والاقتطاع من فمه وإطعام أفواه الجياع. ورجل كهذا لا يمكن له من معالجة اُموره مع الحسين كما عالجها أبوه، إذ كان الفرق شاسعاً بين الاثنين، وكان منتظراً أن يتمّ التصادم في عهده بل في مطلع هذا العهد.
فلم يكن ثمّة ما يمنع الحسين بعد موت معاوية من إعلان ثورته على يزيد، فالنفوس عبّئت عن آخرها ضدّ هذا الخليفة الجديد؛ فمن جهة يزيد ساهمت الانتهاكات المكشوفة للدِّين في إيغار الصدور ضدّه،
____________________
(1) سيكولوجيّة الشذوذ النفسي / 129.
(2) راجع الفخري لابن طبا طبا الطقطقي / 103، والبلاذري في أنساب الأشراف.
إذ لم يكن له قدرة أبيه على الاحتفاظ بالغشاء الديني الذي كان يسبغه على أقواله وأفعاله.
ومن جهة الحسين ساهم موت معاوية في تحلّله من العهد والميثاق، ولم يعد ملتزماً أمام أحد ليبرّر قعوده، وها هو يزيد يقدّم له إشارة البدء بما بدأ به من رعونة وحماقات في مستهلّ عهده.
فما أن وُرِيَ معاوية التراب حتّى عجّل يزيد بأخذ البيعة لعهده من زعماء المعارضة، مدّعياً أنّه رأى في منامه كأنّ بينه وبين أهل العراق نهراً يطرد بالدم جرياً شديداً... وقد جهد ليجوزه، فلم يقدر حتى جازه بين يديه عبيد الله بن زياد وهو ينظر إليه. وكانت هذه أكذوبة افتتح بها عهده كما اختتم أبوه عهده وحياته باُكذوبات مماثلة تحدّث فيها عن رؤى قدسية لم تجُل إلاّ في خياله المريض.
وما لبث أن كتب إلى الوليد بن عتبة واليه على المدينة يخبره فيه بموت أبيه، ومرفقاً به صحيفة صغيرة ذكر له فيها: أمّا بعد، فخذ الحسين وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن الزبير بالبيعة أخذاً شديداً ليس فيه رخصة(1) ، ومَن أبى فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه(2) .
وما جاء في هذه الصحيفة يعطي دلالة شاملة على شخصيّة يزيد. إذ في أوّل كُتبه لأحد وُلاتِه يطلب منه أخذ الحسين وجماعته بالشدّة، ويأمره بقطع رؤوسهم
____________________
(1) الكامل - ابن الأثير 3 / 263.
(2) مقتل الحسين (عليه السّلام) - الخوارزمي 1 / 178 - 180.
وإرسالها له إن أبَوا بيعته. وها هو بأوّل تحرّك له يخالف آخر وصيّة لأبيه على فراش الموت حينما قال له فيما قال: إن خرج الحسين من العراق وظفرت به فاصفح عنه؛ فإنّ له رحماً ماسّة وحقّاً عظيماً وقرابةً من محمّد (صلّى الله عليه وآله)، فإن قدرت عليه فاصفح عنه، فإنّي لو أنّي صاحبه عفوتُ عنه.
ولكن يزيد صاحب الشخصية العصابيّة التي تفتك بأقرب الناس لها دون أن يرفّ لها جفن لم تكن لتهمّه كثيراً قرابة الحسين من محمد (صلّى الله عليه وآله)، ولا تهزّه قرابة الرحم الماسّة؛ إذ إنّ كل همّه الشدّة وإلاّ كان قطع الرؤوس هو البديل للإذعان لهذه الشدّة(1) .
ولكن الحسين (عليه السّلام) الذي انتظر هذه الفرصة طويلاً وصبر على معاوية حتى أيس منه أغلب صحبه، هبّ سريعاً، وكانت ردة فعله مدروسة؛ إذ قال للوليد لمّا فاتحه بكتاب يزيد: «مثلي لا يبايع سرّاً، ولا يجتزئ بها منّي سرّاً، فإذا خرجت للناس ودعوتهم للبيعة ودعوتنا معهم كان الأمر واحداً»(2) .
فاقتنع الوليد لكن مروان قال له: لئن فارقك الساعة ولم يبايع لا قدرتَ منه على مثلها أبداً حتّى تكثّر القتلى بينكم
____________________
(1) كان يزيد (سيكوباتياً) وفي علم النفس السيكوباتية تعني إيقاع الأذى رغم معرفة مقترفها بالقانون والأعراف. إذ إنّ لذّة المقترف الكبرى تتجلّى في اقتراف ما يعرفه أنه جريمة تمام المعرفة.
(2) تاريخ الطبري 6 / 189.
وبينه، فاحبس الرجل حتّى يبايع أو تضرب عنقه. فوثب له الحسين قائلاً: «ويلي عليك يابن الزرقاء! أنت تأمر بضرب عنقي أم هو؟! كذبت ولؤمت وأثمت»(1) . وارتدّ إلى الوليد وقال: «أيّها الأمير، إنّا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا ختم، ويزيد فاسق فاجر شارب الخمور وقاتل النفس المحرّمة معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون، وننظر وتنظرون أيّنا أحقّ بالخلافة»(2) .
فأغلظ الوليد في كلامه وتطايرت الكلمات، فهجم تسعة عشر رجلاً جاؤوا مع الحسين منتضين خناجرهم وأخرجوه(3) . فقال مروان للوليد: عصيتني! فوالله لا يمكنك على مثلها. قال الوليد: وبّخ غيرك يا مروان، اخترت لي ما فيه هلاك ديني؛ أقتل حسيناً إن قال لا اُبايع؟ والله لا أظن امرأً يُحاسب بدم الحسين إلاّ خفيف الميزان يوم القيامة(4) ، ولا ينظر الله إليه ولا يزكّيه، وله عذاب أليم(5) .
وهكذا فبعبارة «ومثلي لا يبايع مثله» ختم الحسين (عليه السّلام) صيحة تحدّيه
____________________
(1) تاريخ الطبري، وابن الأثير، والإرشاد، وإعلام الورى نقلاً عن المقرّم.
(2) مثير الأحزان - لابن نما الحلي.
(3) مناقب ابن شهر آشوب 2 / 208.
(4) تاريخ الطبري 6 / 19.
(5) اللهوف / 13.
ليزيد، وبدأ بالخطوة الأولى في رحلة الألف ميل نحو مصارع شهادته. وهذه العبارة فيها من الإيجاز ما لا يستوعبه مجلد بالشرح المستفيض. فقوله (عليه السّلام) (ومثلي) معناه أنّ مَن كان مثله على دين الحق وسلالة النبوّة لا (يبايع مثله) مَن كان على باطل الأباطيل، وسليل مغتصبي حقّ آل البيت.
وحينما ألقاها ارتفع من أمامه آخر الحواجز النفسية والزمنية، ووضعته العناية الإلهية أمام دوره العظيم في مسيرة الدين الإسلامي، فصار منذ هذه اللحظة بطل هذه العناية وخادمها، ومنفّذ إيحاءاتها العُلوية التي ستقوده إلى قدره المكتوب والمحتوم. في تلك الليلة خرج الحسين زائراً قبر جدّه الرسول (صلّى الله عليه وآله) وقد أثقله الدور الذي سيقوم به، والذي شعر بأنه صار إليه منذ أعلن كلماته أمام الوليد ومروان، فسطع له نور من القبر، فناجى جدّه قائلاً: «السّلام عليك يا رسول الله، أنا الحسين بن فاطمة، فرخك وابن فرختك، وسبطك الذي خلفتني في اُمّتك، فاشهد عليهم يا نبيّ الله أنّهم خذلوني ولم يحفظوني، وهذه شكواي إليك حتى ألقاك»(1) .
وفي الليلة الثانية خرج إلى القبر يصلّي ويدعو الله بحقّ القبر أن يختار له ما يرضى به عنه ولرسوله رضى، ثمّ بكى. وما لبث أن غفا على القبر، فإذا برسول الله (صلّى الله عليه وآله) قد أقبل في كتيبة من الملائكة عن يمينه وشماله وبين يديه، فضمّ سبطه بين يدَيه إلى صدره، وقبّل عينَيه وقال:
____________________
(1) أمالي الصدوق / 93.
«حبيبي يا حسين، كأنّي أراك عن قريب مرمّلاً بدمائك، مذبوحاً بأرض كرب وبلاء مع عصابة من اُمّتي، وأنت مع ذلك عطشان لا تُسقى، وظمآن لا تُروى، وهم مع ذلك يرجون شفاعتي! لا أنيلهم شفاعتي يوم القيامة. حبيبي يا حسين، إنّ أباك واُمّك وأخاك قد قَدِموا عليَّ وهم مشتاقون إليك، وإنّ لك لدرجات في الجنان لا تنالها إلاّ بالشهادة». فجعل الحسين ينظر إلى جدّه ويقول: «يا جدّاه، لا حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا، خذني إليك، وأدخلني معك في قبرك».
وعبارة الحسين (عليه السّلام) الأخيرة تصوّر أدقّ تصوير هول ما سيصيبه ممّا جعله يطلب من جدّه إدخاله إلى قبره، وهذا التصوير يدلّ على همجيّة الذين سيؤذونه أكثر ممّا يصوّر شعوره من هذا الإيذاء وعلى قسوة ما سيناله، لا على خوفه منه.
ولعلّ التصوير الأشدّ بروزاً لهذه الهمجيّة ما جاء في قول جدّه (صلّى الله عليه وآله) له عند قبره من أنّه سيراه قريباً مرمّلاً بدمائه، مذبوحاً مع عصابة من اُمّته.
فوصف (عصابة من اُمّتي) فيه إشارة إلى نوعية اُولئك الذين سيتولّون الذبح، فهُم عصابة، والعصابة تتكوّن من مجموعة أشرار غلاظ الضمائر والقلوب، قساة الصدور والأنفس، وقد حدّدهم (صلّى الله عليه وآله) بأنّهم (من اُمّتي). أيّ تلك الطغمة الفاسدة من الاُمّة الإسلاميّة الخارجة عن العرف والقانون والأخلاق مثلُها مَثل عصابات السرقة والإجرام وانتهاك الحرمات.
ثمّ يصوّر الرسول الكريم (صلّى الله عليه وآله) شناعة موقف هذه العصابة بقوله لسبطه: «وأنت مع ذلك عطشان لا تُسقى، وظمآن لا تروى» ويبسط أمام البصائر وحشيّة العصابة التي تذبح حفيده، والتي لا تكتفي بالذبح بل مع ذلك تتركه عطشان وظمآن لا
يُسقى ولا يُروى، وبهذا الفعل الاضطهادي لا تعطيه الحقّ البسيط الذي يعطى لأعتا المجرمين قبل إعدامه حينما يُسأل عن آخر رغباته، والتي يكون أبسطها السّقي والإرواء.
ويعطف النبي (صلّى الله عليه وآله) هذه الفعلة على ما بعدها والتي ستكون من جانبه (صلّى الله عليه وآله)، إذ يكمل: «وهم مع ذلك يرجون شفاعتي! لا أنيلهم شفاعتي يوم القيامة»(1) .
فعبارتا (وأنت مع ذلك) و (هم مع ذلك) فيهما ربط النتائج بالمسبّبات، وردّ الفعل إلى النيّة في الفعل، وإبراز الفَرق بين ما يجب أن يكون وبين ما لا يجب أن يكون، أو كان فعلاً خارجاً عن المألوف وحدود الكينونة الطبيعيّة.
فالقتل في عرف القانون هو جريمة لها حدودها الماديّة والقانونيّة والشخصيّة والدينيّة، إذا تمّ ضمن هذه الحدود اعتبر قتلاً في خانة الجريمة الصرفة، أمّا إذا سبقه تعذيب فيعتبر في عرف القانون جريمة أخرى تسبق الجريمة الحقيقية من شأنه مضاعفة العقوبة لها، وإذا ما تبع القتل تمثيل بالجثة فإنّ هذا الفعل يعتبر أيضاً جريمة اُخرى أشنع من القتل(2) ؛ لأنّ التمثيل هو إهانة الميّت، وتعذيب لروحه التي لا تترك مسرح مصرعها إلاّ بعد أن توارى الجثّة
____________________
(1) في سفر التكوين 3 / 11 أنّه حين قتل قابيل أخاه هابيل كلّمه الله قائلاً: فالآن ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دماء أخيك من يديك.
(2) يرى فيكتور ماسيون المشرّع الفرنسي بأنّ التمثيل بالجثّة جرم أكبر من جرم القتل ذاته، ويعتبر أنّ للميّت حرمة لا يجوز إهانتها، فإذا أهينت اعتبرت إهانة للرب خالق الهيكل البشري ومكوّنه على صورته ومثاله.
التراب (كما يرى بعض الروحانيين)(1) .
وهكذا فإنّ التعذيب والقتل والتمثيل تعتبر جرائم ثلاثاً في عرف القانون. فإذا نظرنا بهذا المنظار القانوني إلى مقتل الحسين، وكيف عذّب قبل الذبح ثمّ ذُبح ومُثّل بجسده الطاهر أشنع تمثيل وأشدّه مهانة، لتفسّرت لنا مقولة النبي (صلّى الله عليه وآله) لسبطه بهذا الشكل من التعبير(2) .
والرسول الأعظم (صلّى الله عليه وآله) لم يترك ولده يعاني خوف الشهادة، وهو الذي رآه يبكي على صدره ويسأله إدخاله في قبره، بعد زهده في العودة إلى الدنيا، فقال (صلّى الله عليه وآله) له: «لا بدّ أن ترزق الشهادة؛ ليكون لك ما كتب الله فيها من الثّواب العظيم، فإنّك وأبوك وعمّك وعمّ أبيك تحشرون يوم القيامة في زمرة واحدة حتّى تدخلوا الجنة».
إذاً فإنّ انتظار الحسين كلّ هذه المدّة وصبره على مكاره معاوية لم يكن كما فسّره الملفّقون من أنّه جبن وخوف. وخروجه إلى الشهادة بالشكل الذي خرج به لم يكن كما أوّله المخرصون من أنّه خروج عاطفي، لا يحسب لصراع القوّة حساباً؟
فالحسين (عليه السّلام) لم يأتِ بأمرٍ من عنديّاته، بل كان مسيّراً ليس له خيار، فما قول
____________________
(1) للروحاني الفرنسي الكبير، نوستر اداميس (علم خاص في بقاء روح الإنسان حائمة فوق الجسد الذي تركته لساعات أو أسابيع لا تقوى على فراقه تأسّياً عليه، وخوفاً من انفلاتها طليقة، وللروحانيين الشرقيين آراء عدّة في هذا الصدد، ومنها أنّ البكاء حول الميّت يحزنه؛ لأن روحه تحوم وتراقب ولا تبرح بعيداً عن الجسد حتى يوارى التراب. والله أعلم.
(2) القتل يستجلب لعنة الله. وقد جاء النهي عنه في الإنجيل والقرآن والتوراة، على قدر خطورته الدينية والاجتماعية والإنسانية؛ لأنّ الإنسان مخلوق على صورة الله ومثاله، وقتله معناه تغييب لصورة الله ومثاله فيه. وإزهاق لوديعة غالية أودعها الله في هيكله البشري. فكيف إذا كان المقتول قبساً من النبوّة وبضعة من الرسولية. وجزءاً كبيراً من محبّة الله للإنسان... ونفحة قوية من إلهاماته وسرّه...!.
الذين قالوا بعكس ذلك بكلمة الرسول (صلّى الله عليه وآله) لسبطه «لا بدّ أنّ ترزق الشهادة ليكون لك ما كتب الله فيها». وهل بعد تنبّؤ الأنبياء ادّعاء، وهل بعد تقريرهم نقض؟
واُولئك الذين وضعوا ويضعون شهادة الحسين على مشرحة الحروب العسكريّة والصراعات البشريّة من أجل مغانم زمنيّة مؤقّتة، أمَا علموا أنّ حركته كانت استشهاداً وفداءً من حيث كان يقصد بها ذلك قبل أن يقوم بها بزمنٍ بعيد كما حلّلنا ذلك في مطلع كتابنا؟! أمَا لفت بصيرتهم إلى كون الشهادات العظيمة تشابهت في الشكل والوسائل والنتائج، وإنّها دوماً كانت تبدأ من أضعف المواقف حيث تستلزم القوّة، ومن أقوى المواقف حيث يستلزم الضعف؟!
أمَا قرؤوا نبوءات الرسل والوصيّين عن الشهداء الذين سيأتون بعدهم لإنقاذ العقائد وبني البشر من غيّهم وضلالهم، وانتشالهم من بؤر الظلم إلى شمس الحقّ، فيوفّروا على أنفسهم اجتهادات تؤول مصائرها إلى الرياح تذروها بدداً حيال سطوع وتجلّي الحقيقة الإلهيّة الجوهريّة التي لن يعلو على سناها سناء، ولا على إشعاعها إشعاع؟! فهي كالشمس، واجتهادات المحرّفين عُمي الأبصار والبصائر الذين يرون الحقيقة فيشيحون بوجوههم عنها، هي كظِلالٍ باهتة لأشجارٍ عرّيت من أثمارها وورقها، وعصفت بها أرياح الشتاء.
فما أعجب أولئك الموتورين الذين كفروا بنعمة الله تعالى الذي أعطاهم نعمة (الكلمة) فألصقوا بها المعايب والسوءات، وسكبوها على الورق تحريفاً لكلام الله وكلام رسله وأوصيائه، فمَن لهم بشفيع يوم القيامة، ومَن لهم بمنقذ من هواتف صدورهم إذا ما استيقظت ضمائرهم وهتفت في داخلهم تطلب ماء الرحمة والإيمان لتبرّد به جحيمها؟
يا ليت مَن يمنع المعروفَ يمنعهُ |
حتّى يذوقَ رجالٌ غبّ ما صنعوا |
|
وليت للناس خطّاً في وجوههمُ |
تبين أخلاقُهمْ فيه إذا اجتمعوا |
|
وليت ذا الفحش لاقى فاحشاً أبداً |
ووافق الحلمَ أهلُ الحلم فابتدعوا(1) |
____________________
(1) هذه الأبيات لأبي دعبل الجمحي، وقد أثبتناها هنا للاستشهاد بمعناها الموافق مع معاني الرأي الذي سبقها.
الفصل الثاني
الخروج إلى مكّة
ألا يا عينُ فاحتفلي بجهدِ |
ومَن يبكي على الشهداءِ بعدي |
|
على قومٍ تسوقهمُالمنايا |
بمقدارٍ إلى إنجاز وعدِ |
هذا الهاتف سمعته العقيلة زينب وركب الخروج على مشارف الخزيمية قرب الكوفة وأعلمت به أخاها الحسين، ولكنّ الشهيد الذي كان في هذا الموضع امتثالاً لأمر جدّه، لم يزد جوابه على كلام اُخته عن القول: «يا اُختاه، كلّ الذي قُضي فهو كائن»(1) .
وبجواب الحسين يضع ما كتب له في الصحيفة الإلهيّة في موضع التنفيذ بامتثاله
____________________
(1) راجع ابن نما / 23.
للوعد الذي قدّر له إنجازه، فكان كلّ ما قُضي بالنسبة إليه فهو كائن لا محالة، وتأكيد جدّه الرسول الأعظم على ضرورة أن يرزق الشهادة فيه توكيد وأمر غير مباشر له كي لا يقف أو يتردّد، بل يقدِم عن وعي وتبصّر بالنتائج.
وهذا ما كان منه بعد تلقّي التوكيد - الأمر - من جدّه (صلّى الله عليه وآله)، إذ جمع عائلته وصحبه وأنبأهم برؤياه، فتخوّف عليه الجميع ونصحه عمر الأطرف بالمبايعة ليزيد وإلاّ سيقتل، وقال له محمّد بن الحنفيّة ناصحاً: تنحّ ببيعتك عن يزيد بن معاوية والأمصار ما استطعت، ثمّ ابعث برسلك إلى النّاس فإن بايعوك حمدت الله على ذلك، وإن اجتمعوا على غيرك لم ينقص الله بذلك دينك ولا عقلك(1) .
فاستصوب الحسين نصيحة ابن الحنفيّة وعزم على الخروج إلى مكّة، ودخل المسجد وهو ينشد:
لا ذَعَرتُ السَوامَ في فَلَقِ الصُبـ |
ـحِ مُغيراً وَلا دَعَوتُ يَزيدا |
|
يَومَ أُعطي مَخافَةَ الـمَوتِ ضَيماً |
وَالـمَنايا يَرصُدنَني أَن أَحيدا(2) |
وقبل أن يترك الحسين المدينة كتب وصيّة تعتبر دستور الخروج، أجمل فيها مبدأه وهدف خروجه، وقال فيها ضمن ما قال: «وإنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً، ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنّما خرجت لطلب
____________________
(1) اللهوف / 15، طبعة صيدا.
(2) أنساب الأشراف 4 / 66.
الإصلاح في اُمّة جدّي (صلّى الله عليه وآله)؛ اُريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدّي وأبي علي بن أبي طالب، فمَن قبلني بقبول الحقّ فالله أولى بالحقّ، ومَن ردّ عليَّ هذا أصبر حتّى يقضي الله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين»(1) .
وخرج الحسين من المدينة متوجّهاً إلى مكّة لليلتين من رجب سنة ستّين للهجرة وحوله أهل بيته وإخوته وبنو أخيه وهو يقرأ متخوّفاً طالباً من ربّه تخليصه من القوم الظالمين، ولزم الطريق الأعظم فقيل له: لو تنكّبت الطريق كما فعل ابن الزبير كي لا يلحقك الطلب. فأجاب: «لا والله، لا اُفارقه حتّى يقضي الله ما هو قاض».
وفي مكّة مكث أربعة أشهر يدرس أحوال ناصريه وشيعته، وكانت تَرِده كتبهم تعلن له البيعة وتطلب منه الظهور، وكان أهل الكوفة وأعمالها قد وعدوه بمئة ألف مقاتل إن هو طلب البيعة(2) .
ولكنّ الحسين تمهّل لتبيان جليّة الأمر، وآثر قبل التوجّه إلى الكوفة أن يرسل ابن عمّه مسلم بن عقيل بن أبي طالب، ليهيّئ له الأرضيّة المناسبة لإعلان البيعة، ولهذه الغاية كتب إلى رؤساء الكوفة كتاباً يقول فيه: «أمّا بعد، فقد أتتني كتبكم وفهمت ما ذكرتم من محبّتكم لقدومي عليكم، وقد بعثت إليكم أخي وابن عمّي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل، وأمرته أن يكتب إليَّ بحالكم وأمركم ورأيكم، فإن كتب إليّ أنّه قد أجمع رأي ملئكم وذوي
____________________
(1) للشيخ محمّد عبده رأي يقول فيه: خروج الإمام الحسين (عليه السّلام) على إمام الجور والبغي يزيد كان من باب خذل حكومة جائرة عطّلت الشرع الإسلامي.
وللشيخ عبد الله العلايلي في كتابه (الإمام الحسين) / 344 رأي مماثل يقول فيه: إنّ الحسين (عليه السّلام) لم يخرج على إمام، وإنّما خرج على عادٍ فرض نفسه فرضاً، أو فرضه أبوه بدون ارعواء. وهذا مأخذ نيابي وغلطة سياسيّة من معاوية، أعدّ المجتمع للثورة إعداداً قويّاً حينما عهد إلى يزيد.
(2) وردت تفاصيل هذه الكتب وأعدادها وصيغها في كتاب ابن نما / 11، وفي الخوارزمي 1 / 193 تفصيل آخر لاجتماع أهل الكوفة وكتبهم إلى الحسين، عن المقتل للمقرّم.
الفضل والحجى منكم على مثل ما قَدِمت عليَّ به رسلكم وقرأتُ في كتبكم، أقدمُ عليكم وشيكاً إن شاء الله. فلعمري ما الإمام إلاّ العامل بالكتاب، والآخذ بالقسط(1) ، والدائن بالحقّ، والحابس نفسه على ذات الله، والسّلام».
وبينما الحسين في مكّة كان موسم الحج قائماً، وقد غصّت مكّة بجمع كبير من المعتمرين المسلمين من كلّ الأنحاء، وكانت أخبار خروج الحسين قد وصلت إلى الاُمويّين معلنة غضبته وعلنيّة حركته، مع ما وافاهم به جواسيسهم المبثوثة من عقد الأندية للحسين وكثرة اجتماعاته مع المسلمين المتواجدين في مكّة، إضافة إلى ما تناقلته الشائعات والتكهّنات من أقوال وآراء حول هياج أهل الكوفة وغليان نفوسهم بعد موت معاوية.
وكان أن قرّر الاُمويّون اغتيال الحسين في مكّة حتّى ولو كان متعلّقاً بأستار الكعبة، فأرسلوا فرقة يطلق عليها (شياطين بني اُميّة) مؤلّفة من ثلاثين رجلاً لتنفّذ عمليّة اغتياله.
وقد هدف يزيد من وراء اغتيال الحسين ضرب عصفورين بحجرٍ واحد، فمن جهة يتخلّص من خصمه، ومن جهة اُخرى يكون مقتله ذريعة مناسبة لإعدام المئات تحت ستار البحث عن قاتل الحسين، ممَّن يودّ اجتثاثهم وتصفيتهم.
وكان قد بلغ الحسين أنّ مسلماً قد بايعه في الكوفة ثمانية عشر ألفاً فقرّر التعجيل بالسفر إلى الكوفة لسببَين؛ أولهما: من أجل التفويت على اغتياله والمحافظة على حرمة الحرم، وثانيهما: من أجل المبادرة إلى المُبايعين قبل أن يتفرّق شملهم وتبرد هممهم من طول الانتظار.
____________________
(1) يقول الكتاب العزيز:( وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) (سورة الحجرات / 9).
وحاول البعض نصحه بالتريّث أو العدول عن السفر إلى الكوفة، ومنهم عبد الله بن عبّاس إذ سأله: إنّ الناس أرجفوا أنّك سائر إلى العراق، فما أنت صانع؟ أجاب: «قد أجمعت السير في أحد يوميّ هذين». فأعاذه ابن عبّاس بالله من هذا العزم، وقال له مشفقاً: إنّي أتخوّف عليك من هذا الوجه الهلاك، إنّ أهل العراق قوم غدر، أقم بهذا البلد فإنّك سيّد أهل الحجاز، فإن كان أهل العراق يريدونك كما زعموا فلينفوا عدوّهم ثمّ أقدم عليهم، فإن أبيتَ إلاّ أن تخرج فسِر إلى اليمن فإنّ بها حصوناً وشعاباً ولأبيك بها شيعة(1) .
فقال له الحسين: «يابن عمّ، إنّي أعلم أنّك ناصح مشفق، ولكنّي قد أزمعت على السفر، وأجمعت على السير». قال ابن عبّاس: إن كنت لا بدّ فاعلاً فلا تخرج أحداً من ولدك ولا حرمك ولا نسائك، فخليق أن تقتل وهم ينظرون إليك كما قُتل ابن عفّان. ولكن صَحْب الحسين وخلصائه لم يعوا تماماً كما وعى هو أمرَ أن يتوجّه إلى العراق حيث مصرع شهادته، وكانوا حتّى وصوله إلى كربلاء ما زالوا ينظرون إلى
____________________
(1) أبو مخنف في المقتل / 41.
الخروج على أنّه مناجزة عسكريّة، وكان هذا الفهم المغلق سرّاً من الأسرار العُلويّة لم يتفتّح إلاّ لبصيرة الحسين وحده.
إلى الكوفة
في الثامن من ذي الحجّة خرج الحسين قاصداً الكوفة مَوطن المعارضة لاُميّة، وكانت أخبار تَنَادي الشيعة وكُتبها للحسين، والتفافهم حول مسلم بن عقيل بانتظار قدومه قد بلغت يزيد، فاستشار كاتبه وأنيسه سرجون الرومي بما يجدر عليه فعله، فأشار عليه بعزل والي الكوفة النعمان بن بشير، وتولية عبيد الله بن زياد والي البصرة(1) .
وما أن جاء الأمر لابن زياد حتّى تعجّل المسير إلى الكوفة ودخلها متخفّياً بثياب يمنيّة وعمامة سوداء، فكان الناس يظنّونه الحسين ويحيّونه بقولهم: مرحباً بابن رسول الله. وكان الغيظ يحرقه إلى أن وصل إلى قصر الإمارة، فأطلّ عليه النعمان وقال له: ما أنا بمؤدّ إليك أمانتي يابن رسول الله. فقال له ابن زياد: افتح فقد طال ليلك. فعرفه ابن النعمان(2) .
وكان أوّل عمل قام به في الصباح أن جمع مشايخ المدينة في الجامع الأعظم وخطبهم وحذّرهم ومنّاهم بالأعطيات قائلاً: أيّما عريف وجِد عنده أحد من بغية أمير المؤمنين ولم يرفعه إلينا صُلب على باب داره(3) .
____________________
(1) كانت اُمّ عبيد الله بن مرجانة مجوسية. وعند ابن كثير في البداية، وعند العيني في عمدة القارئ شرح البخاري أنها سبية من أصفهان، ويقال: إنّ عبيد الله كان أكولاً. وفي المعارف لابن قتيبة / 256، كان طويلاً جداً، لا يُرى ماشياً إلاّ ظنّوه راكباً.
(2) تاريخ الطبري 6 / 201.
(3) الإرشاد.
وكان يقصد بـ(بغية أمير المؤمنين) الحرورية وأهل الريب.
وأحدث قدوم ابن زياد اضطراباً بين الناس وانتشر الرعب في المدينة، وسرت شائعات بأنّ جيش الشام على الأبواب، وأمسكت القبائل بزعمائها حفظاً لهم من فتك ابن زياد، وبقي البعض يتردّد على مسلم بن عقيل بحذر وتكتّم تحت مراقبة اُمويّة شديدة.
وعلى الرغم من تضارب الوقائع فيما تلا من أيّام بعد وصول ابن زياد إلى الكوفة، فإنّ من المسلّم به أنّ عبيد الله بن زياد لاقى مقاومة وسجالاً في مغالبة مسلم وشيعته، وقد قيل: إنّه هرب مرّة من المسجد واعتصم بقصره هرباً من ناصري مسلم الذين تصايحوا ضدّه.
ويقال: إنّه اجتمع لمسلم أربعة آلاف نصير فأمر بمَن ينادي في الناس بشعار المسلمين يوم بدر: (يا منصور، أمت). ثمّ تقدّم إلى قصر الإمارة مع أنصاره، ولم يكن في القصر إلاّ ثلاثون رجلاً من الشرطة وعشرون من أهل الكوفة، فلمّا شعر ابن زياد بأنّه في خطر تحايل على الموقف وأنفذ عيونه وأنصاره يبثّون الشائعات في المدينة عن قرب وصول المدد من الشام، ويهدّدون بأخذ البريء بالمذنب والغائب بالشاهد.
وأثمرت حيلته، فصارت الزوجات يتعلّقن بأزواجهن كي يمنعنهم من الخروج، وفعل ذلك الإخوة والاُمهات(1) .
وكان أن انفضّ جُند مسلم إلاّ خمسمئة، وما أن صلّى المغرب حتّى كان وراءه ثلاثون أخذوا يتسلّلون رويداً رويداً حتّى بقي وحيداً في المسجد.
____________________
(1) راجع تاريخ الطبري 6 / 207.
ولمّا سمع عبيد الله سكون الجلبة أرسل حملة القناديل ليفتّشوا في المسجد مخافة أن يكون هذا السكون مكيدة، فلمّا اطمأنّ إلى تفرّق أتباع مسلم دعا إلى الصلاة، ولمّا اجتمع الناس رقى المنبر وقال: إنّ ابن عقيل قد أتى ما قد علمتم من الخلاف والشقاق فبرأت الذمّة من رجل وجدناه في داره ومَن جاء به فله ديّته.
ثمّ أمر رئيس شرطته الحصين بن نمير أن يفتّش السكك ودور الكوفة، وتوعّده بالقتل إن أفلت مسلم وخرج من الكوفة(1) .
وعند الصباح وشى ابن امرأة تُدعى (طوعة) كانت قد آوت مسلماً بمكان اختبائه، فأرسل ابنُ زياد ابنَ الأشعث في سبعين من الشرطة فقبضوا عليه بعد معركة دامية دافع خلالها ابن عقيل دفاع الأبطال، وقتل العديد من مهاجميه(2) .
ولمّا جيء به إلى ابن زياد رأى مسلم على باب القصر قلّة ماء مبردة، فطلب شربة منها، فقال له مسلم بن عمرو الباهلي: والله لا تذوق منها قطرة حتّى تذوق الحميم في نار جهنّم.
ولمّا مثل بين يدي عبيد الله لم يحيّه، فقال له ابن زياد: لقد خرجت على إمامك وشققت عصا المسلمين، وألقحت الفتنة. فقال مسلم: كذبت، إنّما شقّ العصا معاوية وابنه يزيد، والفتنة ألقحها أبوك(3) .
____________________
(1) تاريخ الطبري 6 / 209 - 210.
(2) يقال: إنّه قتل واحداً وأربعين رجلاً على ما ذكر ابن شهر آشوب في المناقب 2 / 212.
(3) ابن نما / 17، ومقتل الخوارزمي / 211.
ونظر مسلم إلى جلساء ابن زياد فرأى بينهم عمر بن سعد فناشده بحقّ القربى بينهما ليصغينّ منه إلى وصيّة ينفّذها له، فأبى عمر. فأذن له عبيد الله، فقام إلى مسلم بحيث يراهما ابن زياد، فأوصاه مسلم بأن يقضي دَيناً عليه بالكوفة سبعمئة درهم بعد أن يبيع سيفه ودرعه، ويستوهب جثّته من ابن زياد ويدفنها، ويكتب إلى الحسين بخبره.
ولكنّ رجل عبيد الله كان أميناً مع نذالة نفسه فأفشى لسيّده بسرّ مسلم، فأمره بالتكتّم على هذا السرّ، وأمر بإخراج مسلم إلى أعلى القصر حيث تراه الجموع المنتظرة في الخارج، وطلب من رجل شامي أن يضرب عنقه. فسقط رأسه إلى الرحبة واُلقيت جثّته إلى الناس، ثمّ أرسل برأسه إلى يزيد مع رؤوس بعض أنصاره ممَّن كان يأوي إليهم وفي مقدّمتهم رأس هانئ بن عروة، ثمّ أمر بسحب مسلم وهانئ بالحبال من أرجلهما في الأسواق وصلبهما بالكناسة منكوسين(1) .
حينما قُتل مسلم كان قد مضى على خروج الحسين من مكّة يوم كامل ولم يكن قد علم بمقتل ابن عمّه، وكان يغذ السير تاركاً وراءه الدساكر والقرى ووجهته الكوفة.
ومن بطن الحاجر أراد (عليه السّلام) أن يستوثق من بقاء شيعته على مساندتهم له، فأرسل لهم كتاباً يطالبهم فيه بالجِدّ والانكماش في أمرهم، وأرسل الكتاب مع قيس بن مسهر الصيداوي الذي ما أن وصل القادسيّة حتّى وقع في قبضة الحصين بن نمير، الذي سيّره إلى ابن زياد، حيث خرق أمامه الكتاب الذي زوّده به الحسين، فسأله ابن زياد عن سبب تمزيقه للكتاب، وطلب منه أن يخبره عما فيه؟ فأبى قيس.
____________________
(1) في التاريخ نجد كثيراً من قصص الصلب مع إنكاس الرأس. ففي صدر المسيحيّة صلب نيرون مجنون روما بطرساً وبولساً تلميذي المسيح منكوسين، جزاء إدخالهما المسيحية إلى روما. وفي كتاب حياة الحيوان أنّ إبراهيم الفزاري قُتل وصلب منكساً بعد أن أفتى فقهاء القيروان بذلك؛ جزاء هزله بالله والأنبياء. كما أنّا واجدون حتّى في التاريخ الحديث قصص صلب مماثلة جرت باسم الثورات الشعبية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينيّة.
فأمره عبيد الله بصعود المنبر وسبّ (الكذّاب بن الكذّاب الحسين بن علي)، ففعل وقال: أيّها الناس، إنّ الحسين بن علي خير خلق الله، وقد خلفته في موضع الحاجر فأجيبوه، والعنوا ابن زياد وأباه. فما كان من ابن زياد إلاّ وأمر بقذفه من أعلى القصر، فتحطّمت عظامه.
وكان الحسين خلال سيره يسأل الناس عن أحوال الكوفة، فيجمعون على القول: بأنّ قلوب أهل الكوفة معه وسيوفهم عليه، وكان يجيب القائلين: بأنّهم لن ينصرفوا حتّى يقضي الله أمراً، وتتصرّف بهم الاُمور في عاقبة.
ولمّا وصل إلى الثعلبيّة بلغه مسلم وهانئ، فتلقّى ذلك بصبر، وسأل آل عقيل عمّا يرون فعله بعد مقتل مسلم؟ فأبوا الرجوع حتّى يذوقوا ما ذاقه مسلم.
وتوالت الأنباء المزعجة، فقد ورد للحسين نبأ مقتل عبد الله بن يقطر رسوله أيضاً إلى الكوفة، حيث كانت ميتته مثل ميتة مسلم، ملقى به من علٍ مدكوك العظام.
وهنا لم يرَ الحسين مندوحة من أن يعلن لمَن معه تقلّب الأوضاع لغير المشتهى، وخيّرهم بين البقاء أو الانصراف قائلاً: «وقد خذلنا شيعتُنا، فمَن أحبّ منكم أن ينصرف فلينصرف، ليس عليهم منّا ذمام». فتركه معظمهم إلاّ أهل بيته وخلّص أصحابه.
وما أن أشرف الركب على جبل ذي حسم حتّى برزت طلائع جيش عبيد الله بقيادة الحرّ، حيث كان هذا الجيش يجوب القفار بحثاً عن ركب الحسين، ولمّا كان
الوقت ظهيرة والقيظ يخنق الأنفاس، أمر الحسين فتيانه بإسقاء الجيش المعادي، وترشيف الخيل ترشيفاً(1) .
ولمّا علم الحسين بأنّ جيش الحرّ قد جاء لصدّه وأخذه إلى عبيد الله في الكوفة، أمر مؤذّنه بالأذان لصلاة الظهر، ثمّ خطب بالقوم الذين جاؤوا يطلبونه فأخبرهم بأنّه لم يأتِ حتّى أتته كتبهم ورسلهم، وسألهم أخيراً بقوله: «فإن تعطوني ما أطمئنّ إليه من عهودكم ومواثيقكم أقدم مصركم، وإن لم تفعلوا أو كنتم لقدومي كارهين انصرفت عنكم إلى المكان الذي جئت منه إليكم». فسكتوا جميعاً.
وبعد الصلاة عاد الحسين إلى مخاطبة الجيش، فأجابه الحرّ: إنّي اُمرت ألاّ اُفارقك إذا لقيتك حتّى أقدمك الكوفة على ابن زياد. فقال الحسين: «الموت أدنى إليك من ذلك». وأمر أصحابه بالركوب، فحال الحرّ بينهم وبين الانصراف، فقال الحسين للحرّ: «ثكلتك اُمّك! ما تريد منّا؟».
قال الحر: أمَا لو غيرك من العرب يقولها لي وهو على مثل هذا الحال ما تركت ذكر اُمّه بالثكل كائناً مَن كان. والله ما لي إلى ذكر اُمّك من سبيل إلاّ بأحسن ما نقدر عليه، ولكن خذ طريقاً نصفاً بيننا؛ لا يدخلك الكوفة ولا يردّك إلى المدينة حتّى أكتب إلى ابن زياد، فلعلّ الله أن يرزقني العافية ولا يبتليني بشيء من أمرك.
ثمّ حذّر الحسين بقوله: لئن قاتلت لتقتلن؟
____________________
(1) تاريخ الطبري 6 / 226.
فقال (عليه السّلام): «أبالموت تخوّفني؟! بماذا أردّ عليك إلاّ بما قاله أخو الأوس لابن عمّه وهو يريد نصرة رسول الله»:
سأمضي وما بالموتِ عارٌ على الفتى |
إذا ما نوى حقّاً وجاهد مسلما |
|
وواسى رجالاً صالحين بنفسهِ |
وخالفَ مثبوراً وفارق مجرماً |
|
فإنْ عشتُ لم أندم وإنْ متّ لماُلم |
كفى بك ذلاًّ أن تعيش وتُرغما |
فتنحّى الحرّ عن الحسين، وأخذ يسايره بجيشه انتظاراً لوصول كتاب ابن زياد بعد أن أرسل يخبره بالعثور على ركب الحسين. وما أن وصلوا إلى نينوى حتّى وصل رسول يحمل للحرّ أمر ابن زياد الذي يقول فيه: أمّا بعد، فجعجع(1) بالحسين حتّى يبلغك كتابي ويقدم عليك رسولي، فلا تنزله إلاّ بالعراء في غير حصن وعلى غير ماء.
ولمّا فرغ الحر من قراءة الكتاب دفعه للحسين يقرأه، ولمّا فعل طلب الحسين منه أن يسمح لهم بالنزول في نينوى أو الغاضريات، فرفض الحرّ؛ متعلّلاً بأنّ لابن زياد عيناً عليه(2) .
____________________
(1) ذكر الأصمعي أنّ الجعجعة معناها الحبس. وجعجع به معناها: أحبسه. ومنه قول أوس بن حجر: إذا جعجعوا بين الإناخة والحبس عن المقتل للمقرم.
(2) إرشاد المفيد.
وأشار زهير بن القين على الحسين بمقاتلة جيش الحرّ قبل أن يأتيهم من الجند ما لا قِبَل لهم بهم. فقال الحسين (عليه السّلام): «ما كنت أبدأهم بقتال».
وطلب الحسين من الحرّ أن يسمح لهم بالمسير قليلاً، فإذن لهم. فساروا جميعاً حتّى وصلوا إلى أرض كربلاء، فوقف جواد الحسين فجأة ولم يتحرّك، فسأل الحسين عن اسم الأرض التي يقفون فوقها. فقال زهير: هذه أرض الطفّ. فسأل الحسين: «وهل لها اسم غيره؟». قال زهير: تعرف بكربلاء. فدمعت عينا الحسين وقال: «اللّهم أعوذ بك من الكرب والبلاء، ها هنا محطّ ركابنا وسفك دمائنا ومحمل قبورنا، بهذا حدّثني جدّي رسول الله».
في كربلاء
في عشيّة اليوم الثاني من المحرّم سنة إحدى وستّين كان نزول الحسين وركبه في بطاح كربلاء، ومنذ هذا التاريخ تبدأ الفصول الأشدّ حسماً وصعوبة في رحلة الخروج الدامية.
وقد ضرب الحسين خيامه في هذه البقعة، وضرب الحرّ معسكره قريباً منه. وما هي إلاّ فترة بسيطة حتّى كان الخبر يهزّ الكوفة، فاهتزّت وماجت فيها القوى على اختلاف مشاربها، وبدا أنّ العناصر الموالية للحسين تنقصها القيادة التي توجّهها نحو هدفها.
وأسرع ابن زياد فأطلق النفير العام معلناً التعبئة والتجنيد العام، بعد أن أرسل إلى الحسين كتاباً قال له فيه: أمّا بعد يا حسين، فقد بلغني نزولك كربلاء، وقد كتب إليّ أمير المؤمنين يزيد أن لا أتوسّد الوثير ولا أشبع من الخمير، أو ألحقك باللطيف الخبير، أو تنزل على حكمي وحكم يزيد، والسّلام.
وقد قرأ الحسين هذا الكتاب وألقاه على الأرض، وهو يقول: «لا أفلح قوم اشتروا مرضات المخلوق بسخط الخالق». وقال لرسول ابن زياد: «ما له عندي جواب؛ لأنّه حقّت عليه كلمة العذاب». وبجواب الحسين هذا تقرّر فيه كلّ ما سيلي، وانقطع آخر خيط في الحوار الذي كان دائراً بينه وبين جماعة يزيد.
ولمّا أخبر الرسول ابن زياد بما قاله أبو عبد الله (عليه السّلام) ثار ثورة شديدة(1) ، وأمر عمر بن سعد بالخروج إلى كربلاء، وكان معسكراً (بحمام أعين) في أربعة آلاف محارب ليسير بهم إلى (دستبي) بأرض همذان لقمع ثورة الديلم، بعد أن وعده بولاية الري وثغر دستبي والديلم(2) ، بعد تحقيق النصر.
ولكنّه استمهل ابن زياد للمراجعة، فنصحه ابن اُخته ابن المغيرة بن شعبة - وهو من أعوان معاوية - بألاّ يقبل بمقاتلة الحسين، وقال له: والله لئن تخرج من دنياك ومالك وسلطان الأرض لو كان لك، خير من أن تلقى الله بدم الحسين.
____________________
(1) البحار 10 / 189، ومقتل العوالم / 76.
(2) تاريخ الطبري 6 / 232.
وبات ابن سعد ليلته مفكّراً وسُمع يردّد:
أأتركُ ملكَ الرّيِّ والريُّ رغبتي |
أم ارجعُ مذموماً بقتلِ حسينِ |
|
وفي قتله النارُ التي ليس دونها |
حجابٌ وملكُ الريِّ قرّة عيني |
وفي الصباح أتى ابن زياد وطلب إنفاذه على أن يرسل إلى الحسين بعض أشراف الكوفة وسمّى له بعضاً منهم. فأبى ابن زياد إلاّ أن يسير إلى مقاتلة الحسين، أو ينزل له عن ولاية الري، فلمّا رآه ملحّاً سار بجنده وانضمّ إليه الحرّ فيمَن معه، وأنفذ ابن سعد قرّة بن قيس الحنظلي لسؤال الحسين عمّا جاء به إلى هذه الأرض. ولمّا عاده بالجواب، كتب إلى ابن زياد فجاءه جوابه: أعرض على الحسين وأصحابه البيعة ليزيد، فإن فعل رأَينا رأْينا.
وكان ابن سعد قد ذكر لابن زياد أنّ الحسين أعطاه عهداً بأن يرجع إلى المكان الذي أقبل منه، أو يسير إلى ثغر من الثغور، أو أن يأتي يزيد فيضع يدَه في يدِه. والمرجّح أنّ عمر بن سعد نقل عمداً هذا الكلام عن لسان الحسين؛ تخلّصاً من المهمّة الصعبة التي اُنيطت به.
وقد حاول عبيد الله أن يأخذ جانب الليونة بعد ورود كتاب ابن سعد، إلاّ أنّ شمراً نهاه وأوغر صدره على عمر واتّهمه بمحادثة الحسين طوال الليل بين
المعسكرين. فمال ابن زياد لرأي شمر، وأنفذه بأمر أن يضرب عنق عمر إن هو تردّد في تسيير الحسين إلى الكوفة أو مقاتلته، وكتب لعمر كتاباً غاضباً يقول له فيه: فإنّي لم أبعثك إلى الحسين لتكفّ عنه، ولا لتمنّيه السلامة والبقاء، ولا لتطاوله ولا لتعتذر عنه، ولا لتقعد له عندي شافعاً.
انظر فإن نزل الحسين وأصحابه واستسلموا فابعث بهم إليّ مسلّماً، وإن أبوا فازحف إليهم حتّى تقتلهم وتمثّل بهم؛ فإنّهم لذلك مستحقّون، فإن قُتل الحسين فاوطئ الخيل صدره وظهره؛ فإنّه عاقّ مشاق قاطع ظلوم، فإن أنت مضيت لأمرنا جزيناك جزاء السامع المطيع، وإن أنت أبيت فاعتزل جندنا، وخلّ بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكر.
وهكذا انتشر في فلاة كربلاء خمسة وعشرون ألف مقاتل، يحاصرون ثلاثة وسبعين نفراً وبضعة نسوة وأطفال.
وقد حدّث التاريخ على أنّ وسائل النقل في الكوفة قد عجزت عن حمل هذا الجيش إلى كربلاء، وقد بقي الحدّادون في الكوفة يعملون ليل نهار لمدّة عشرة أيام متواصلة في صقل السيوف وبري النبال، كانت نارهم خلالها مضرمة على الدوام.
ورقم الجيوش التي أنفذت لمقاتلة الحسين لم يدخل في خانتها عدد بعض الرماة والفرسان الذين كانوا مع الحصين بن نمير، وعزرة بن قيس، ولو أحصيت لوصل العدد إلى ما فوق الثلاثين ألفاً.
ففي أمالي الصدوق، ذكر الرقم ثلاثين ألفاً، وفي مطالب السؤول ذكر بعشرين، وفي هامش تذكرة الخواصّ بمئة، وفي أسرار الشهادة بستة آلاف فارس وألف راجل، وفي تحفة الأزهار بثمانين ألفاً.
وعلى قعقعة أسلحة هذه الجيوش استعدّت كربلاء لاستقبال شهيدها، ومع اضمحلال غسق ليلة التاسع من محرّم استعدّ الشهيد الحسين (عليه السّلام) لتقديم ذاته على مذبح العناية الإلهيّة قرباناً فداء للإسلام.
آخر أقوال ومواقف سيّد الشهداء
نادى ابن سعد عشيّة الخميس لتسع خلون من المحرّم فأمر جيشه بالزحف نحو معسكر الحسين. وكان أبو عبد الله جالساً أمام بيته، فرأى رسول الله يقول: «إنّك صائر إلينا عن قريب». وسمعت زينب أصوات الرجال وقالت لأخيها: قد اقترب العدوّ منّا.
فقال الحسين (عليه السّلام) لأخيه العباس: «اركب بنفسي أنت حتّى تلقاهم، واسألهم عمّا جاءهم». ففعل العبّاس مع عشرين فارساً، فقالوا له: جاء أمر الأمير أن نعرض عليكم النزول على حكمه أو ننازلكم الحرب(1) . فعاد العبّاس (عليه السّلام) يخبر الحسين، بينما انصرف أصحابه إلى عظة القوم، وما
____________________
(1) راجع روضة الواعظين / 157، والإرشاد - المفيد، والبداية - لابن كثير 8 / 176، وتاريخ الطبري 6 / 137.
لبث أن عاد طالباً منهم استمهالهم العشيّة، فأجابه ابن سعد لهذا الطلب.
وقرب المساء خطب الحسين (عليه السّلام) بصحبه، مخبراً إيّاهم بأنّ جدّه (صلّى الله عليه وآله) أخبره بأنّه سيساق إلى العراق، فينزل أرضاً يقال لها عمورا وكربلا، وفيها يستشهد وقد قرب الموعد(1) . وأذن لهم بالانصراف ودعاهم للانطلاق في حلّ من ذمامه بأن يأخذ كلّ منهم بيد رجل من أهل بيته ويتفرّقوا في سوادهم ومدنهم؛ لأنّ القوم إنّما يطلبونه، ولو أصابوه لذهلوا عن طلب غيره(2) ، ولكنّ الجميع رفضوا إلاّ الموت بين يديه.
وقد روي عن محمّد بن الحنفيّة أنّه قال: قُتل مع الحسين سبعة عشر رجلاً كلّهم من أولاد فاطمة.
وعن الحسن البصري أنّه قال: قُتل مع الحسين ستّة عشر رجلاً كلّهم من أهل بيته وما على وجه الأرض يومئذ لهم شبه.
وتحدّث المصادر(3) بأنّ جيش الحسين كان مؤلّفاً من خمسمئة فارس من أهل بيته وصحبه ونحو مئة راجل؛ أمّا ابن عساكر فيورد أنّ ستّين شيخاً من أهل الكوفة هم جيش الحسين، وقد قاتلوا حتّى قُتلوا معه، إضافة إلى التحاق الحرّ
____________________
(1) راجع إثبات الرجعة.
(2) يرد الفيلسوف الألماني (ماربين) طلب الحسين (عليه السّلام) من أولاده وإخوانه وبني إخوته وبني أعمامه وخواصّ صحبه الانصراف وتركه وحيداً إلى رغبته في فضح بني اُميّة بقتل هؤلاء المعروفين بين المسلمين بجلالة القدر، وعظم المنزلة ممّا سيجعل من قتلهم معه مصيبة عظيمة وواقعة خطيرة. وفي هذا دلالة على حسن سياسته، وقوّة قلبه وتضحية نفسه وأهله في سبيل الوصول إلى المقصد الذي كان في نظره.
(3) راجع مروج المسعودي.
وأخوه وولده ومولاه وبعض جنده، كما أضيف إليهم بعض من عسكر ابن سعد المتسلّلين إلى معسكر الحسين.
ولمّا وثق الحسين من صدق نيّتهم أراد أن ينبّههم إلى ما ينتظرهم في الغد فقال لهم: «إنّي غداً اُقتل وكلّكم تُقتلون معي ولا يبقى منكم أحد، حتّى القاسم وعبد الله الرضيع، إلاّ ولدي علياً زين العابدين؛ لأنّ الله لم يقطع نسلي منه وهو أبو أئمّة ثمانية».
فرفع الجميع أصواتهم مجدّداً شاكرين الله الذي كرّمهم بنصرته وشرّفهم بالقتال معه.
وفي تلك الليلة سمع علي بن الحسين أباه يقول وهو يصلح سيفه:
يا دهرُ أفٍّ لك من خليلِ |
كم لك بالإشراقِ والأصيلِ |
|
من صاحبٍ وطالبٍ قتيلِ |
والدهرُ لا يقنع بالبديلِ |
|
وإنّما الأمرُ إلى الجليلِ |
وكلُّ حيٍّ سالكٌسبيلِ |
وقد أخبر عمّته زينب بما سمعه، فجاءت إلى أخيها تصيح: وا ثكلاه! ليت الموت أعدمني الحياة(1) .
____________________
(1) مقاتل الطالبيّين - لأبي الفرج / 45، وكامل ابن الأثير 4 / 24، ومقتل الخوارزمي 1 / 238.
وبكت النسوة معها، فقال لهنّ الحسين: «يا اُختاه، يا اُمّ كلثوم، يا فاطمة، يا رباب، انظرنَ إذا قُتلت فلا تشقن عليَّ جيباً، ولا تخمشن وجهاً، ولا تقلن هجراً»(1) . ثمّ أوصى (عليه السّلام) اُخته زينب بأخذ الأحكام من ابنه علياً وإلقائها إلى الشيعة ستراً عليه.
وفي السحر من تلك الليلة خفق الحسين ثمّ استيقظ، وأخبر أصحابه بأنّه رأى في منامه كلاباً شدّت عليه تنهشه، وأشدّها عليه كلب أبقع، وأنّ الذي يتولّى قتله من هؤلاء رجل أبرص.
وقد صدق حدسه (عليه السّلام) إذ ما أن رأى شمراً الأبرص حتّى قال: «هو الذي يتولّى قتلي».
وصف ابن رستة في الأعلاق النفيسة شمراً بقوله: كان الشمر بن ذي الجوشن قاتل الحسين أبرص. وفي كامل ابن الأثير ذكر: إنّ الشمر أبرص يرى بياض برصه على كشحه. وفي عجالة المبتدي في النسب للحافظ الهمداني ذكر: أنّ شمراً اسمه (شور بن ذي الجوشن)، ولأبيه صحبة ورواية روى عنه ابنه شور.
وكان الحسين (عليه السّلام) يحدّث أصحابه في كربلاء بما قاله جدّه (صلّى الله عليه وآله) فكان يقول: «كأنّي أنظر إلى كلب أبقع يلغ في دماء أهل بيتي».
____________________
(1) الإرشاد.
الفهرس
الفصل الأوّل. 5
مقدّمة الكتاب.. 7
ضمير الأديان إلى أبد الدهور 7
مقدّمة الطبعة الثانية 17
مقدّمة المؤلِّف.. 21
ثورة الحسين لمَن؟ 59
فداء الحسين (عليه السّلام) في الفكر المسيحيّ. 69
ثورة الوحي الإلهي. 89
الحسينُ يستوحي مقتله 101
معجزاتُ الشهادة 105
حكمةُ اختلاف الشهادتين. 115
معجزات الشهادة في ضمير الإسلام 121
سليلةُ بيت النبوّة 126
المعجزةُ الروحيّة 130
استجاباتٌ فوريّة 131
وارثة مبادئ علي (عليه السّلام) 135
بلاغة السجّاد (عليه السّلام) 137
مهزلةُ الخروج على الأئمّة 140
معجزاتُ الشهادة الاجتماعيّة 143
الأخلاقُ معدن الثورات.. 147
بين مبادئ وأخلاق. 148
في كفّة يزيد. 157
معجزات الشهادة الزمنية 169
ثورةُ المدينة 179
ثورةُ المختار الثقفي. 181
ثورةُ مطرف بن المغيرة 182
ثورةُ ابن الأشعث.. 182
ثورةُ زيد بن علي بن الحسين. 183
الأسبابُ البعيدة للثورة 195
صراعُ موروث.. 197
ولايةُ علي (عليه السّلام) 199
انتقامُ معاوية من شيعة علي. 200
استفحالُ خطر التحريف.. 202
الأسباب القريبة للثورة 205
أ. في عهد معاوية 205
ب. في عهد يزيد. 223
الفصل الثاني. 235
الخروج إلى مكّة 237
إلى الكوفة 242
في كربلاء 249
آخر أقوال ومواقف سيّد الشهداء 253