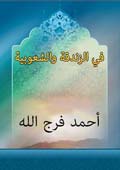في الزندقة والشعوبية
أحمد فرج الله
المقدّمة:
يعالج هذا الكتاب موضوعين شغلا جزءاً كبيراً من التأريخ العربي الإسلامي، الذي قلّما تفتح كتاباً فيه دون أن يواجهك حديث الزندقة والشعوبية، متلازمين أحياناً ومنفصلين أحياناً، ولكنّهما يشيران في كل الأحيان إلى نزعة معادية للعرب أو للإسلام أو لكليهما.
هذا هو مفهوم اللفظين عند مَن يستعملهما وعند مَن يسمعهما، منذ بدأ استعمالهما في القرن الثاني الهجري، ثم اتّسع بعد ذاك خلال القرن الثالث.
ولم أكن لأحفل بالوقوف عند هذين الموضوعين، ولا بالكتابة فيهما لو أنّهما اقتصرا على الماضي، وانحصرت آثارهما فيه، وفي الحاضر أكثر من موضوع يستحق الوقوف عنده والكتابة فيه.
كنت أريد أن أنصرف إلى ما هو أولى بالانصراف إليه من مواضيع الحاضر وقضاياه، لولا ما رأيت من أنّ هذا الذي تصورته - خطأ - جزءاً من ماضٍ انتهى، قد عاد، ونحن في نهايات القرن العشرين، إلى قوّته وأكثر من قوّته: يجرح ويتهم ويهاجم. يَدفع به ويَدفع إليه، مَن كان يَدفَع به ويَدفع إليه في الماضي، مِن قوى ذات نفوذ ومصالح تريد أن تشغل الناس، وتشعل الفتنة وتثير البغضاء والكره بين أبناء البلد الواحد والشعب الواحد؛ لتضمن لنفسها البقاء: مبدأ ليس جديداً، وإن كان له في كل عصر لباس جديد وشعار جديد.
وإذا كانت تهمة الزندقة قد خفّت وقلَّ المهاجمون بها والراكضون إليها، فإنّ الشعوبية (1) ، مع غلبة النزعة القومية ، عادت إلى الظهور ، سلاحاً ضد الفكر الحر الذي يرفض التخلّف والجمود ، والخضوع لمسلّمات كانت وراء ما نعاني مِن تخلّف وجمود ، مع أنّ الفكر الحر هذا ليس شعوبياً ، ولم يكن يوماً شعوبياً ، بحكم طبيعته الحرة ، وليس بين مهاجميه مَن هو أوضح عروبة وأغير عليها ، منه ومن حامليه والمدافعين عنه .
ولا أُريد أن أسبق القارئ، ولا أُريد أن أعرض عليه الكتاب مختصراً في هذه المقدّمة، لكنّي أريد أن أُبدي ملاحظتين سريعتين قبل أن أتركه للكتاب، أو أترك الكتاب له يحكم فيه.
أمّا أُولاهما: فأُلاحظ أنّ الزندقة - وسيلاحظ القارئ ذلك - مفهوم بالغ الغموض عديم الملامح، أو - وهذا ما أذهب إليه - أُريد له أن يكون كذلك، ليسهل استخدامه مِن قِبل السلطة في البطش بمن تشاء، دون حاجة للبحث عن سبب ومبرّر، غير تهمة الزندقة التي تحتمل ألف شكل، مع أنّ هذه السلطة لم تكن يوماً عبر تأريخها، في حاجة إلى السبب والمبرّر لما تفعل.
وأمّا الثانية من الملاحظتين فتخص الشعوبية: هذه (الحركة) التي أُسيء فهمها فأُسيء النظر إليها. ضخمت حتى صُوِّرت وكأنّها كادت أن تهدّ ما بناه العرب من حضارة ومجد، وربّما ما تزال وراء ضعف العرب وتفكّكهم. وما كانت الشعوبية في أي من مراحلها بالقوة والتأثير الذي يمنحونه لها، وما كانت في أي من مراحلها بقادرة على القيام ببعض ما نُسب إليها. لقد كانت (تنفيساً) إذا جاز التعبير، عند بعض الأفراد والجماعات غير العربية، الفارسية على وجه الخصوص، يواجهون به الاستعلاء والازدراء عند بعض العرب، فكان ردّهم على ذلك، أن رجعوا إلى ماضيهم الثري القريب، يتغنّون مآثره، ويتأسّون به عن حاضر لا يعترف بهم.
وبعد فهذا هو الكتاب بين يدي القارئ، وهو وحده مَن يحكم فيه.
____________________
(1) لا أقصد الثورات التي قامت بها شعوب للمطالبة باستقلالها عن الدولة العربية كثورة بابك الخرمي، فليست تلك ممّا يُعالَج تحت اسم الشعوبية، ولم يعالجها المؤرّخون العرب أنفسهم تحت هذا الاسم.
أحمد
8/ 1 / 2008
مونتريال - كندا
الإهداء:
إلى الذين دفعوني إلى الكتابة في موضوع الزندقة والشعوبية ممّن لم يقرؤوا التأريخ أو قرؤوه ولم يفهموه أو فهموه وزوّروه.
أهدي هذا الجهد...
أحمد / بغـداد في 11/3/2003
القسم الأوّل:
فـي الزندقة
أذكر أنّني تساءلت وأنا أكتب عن المرجئة، عمّا هو مقصود بهذا الاصطلاح الذي بلغ من السعة أنّك تستطيع أن تعد ستة أو سبعة وجوه أو أكثر، كلها تصلح أن تسمّى إرجاء، ويسمّى مَن يأخذ بها، وبأي منها، مرجئاً، دون الوقوع في خطأ.
وأراني اليوم أواجه نفس القضية، أو نفس المشكلة وأنا أريد الكتابة عن الزندقة. فما المقصود بالزندقة التي أشغلت الرأي العام الإسلامي، فترة ليست بالقصيرة، وتعرّض بسببها أو بسبب الاتهام بها، عدد من المفكّرين للقتل أو التعذيب أو التشريد.
ما الذي يجمع الوليد بن المغيرة إلى عبد الله بن المقفّع، والعاص بن وائل إلى أبي حيان التوحيدي، والوليد بن يزيد إلى أبي العلاء المعرّي، وكلهم متهمون بالزندقة مشمولون بالانتساب إليها.
ما الذي يجمع هؤلاء أو يقرّب بينهم من نسب أو فكر أو مذهب، ليمكن للمؤرّخين وأصحاب المقالات من المسلمين، أن يطلقوا عليهم جميعاً، اسم الزنادقة، دون أن يجدوا في ذلك حرجاً أو مأثماً، يمنعهم من هذا التخليط الذي كان خيراً لهم منه، سكوت لا يضر صاحبه ولا يضلل قارئه.
عليّ إذن أن أُحدّد مفهوم الزندقة أوّلاً، وهل أراد المؤرّخون وأصحاب المقالات من ذلك، مذهباً بعينه أو اخترعوا هم مذهباً بعينه، اسمه الزندقة واسم أتباعه الزنادقة، ليصح بعد، أن نصف شخصاً ما بأنّه زنديق. أم أنّ الزندقة كانت تهمة تتسع حتى تلحق أي شخص ترى فيه السلطة - آنذاك - تهديداً لها بأيّ شكلٍ ظهر هذا التهديد.
الفصـل الأوّل:
مفهوم الزندقة عند المسلمين
لكي نعرف ما هو مفهوم الزندقة عند المؤلّفين من المسلمين، سأضع أمامك سيدي القارئ، ثبتاً بأسماء عدد، ممّن يعتبرهم هؤلاء: زنادقة.
وأنا لا أدعي أنّ مَن ذكرتهم هم كل الزنادقة. وإنّما هم الذين تتردّد في الغالب أسماؤهم في المصادر التي تتناول الموضوع، والذين عثرت عليهم فيها، وأنا أعد لهذا الكتاب.
وإذا كنت ترى أنّي أثقلت عليك بكل هذه الأسماء. فعذري أنّ ذلك قد يكون ضرورياً، لتتمّ المناقشة في حدود العلم، دون شطط أو اجتهاد.
1ـ الوليد بن المغيرة (والد الصحابي خالد بن الوليد).
2ـ أبو سفيان (قبل إسلامه).
3ـ عقبة بن أبي معيط
4ـ العاص بن وائل السهمي (والد الصحابي عمرو بن العاص).
5ـ أُبي بن خلف
6ـ منبّه بن الحجاج
7ـ نبيه بن الحجاج
8ـ يحيى بن زياد
9ـ بشّار بن برد
10ـ أبو نواس
11ـ آدم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز
12ـ والبة بن الحباب
13ـ مطيع بن إياس
14ـ يعقوب بن الفضل الهاشمي
15ـ علي بن داود العباسي
16ـ داود بن روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلّب بن أبي صفرة
17ـ عبد الله بن المقفّع
18ـ منقذ بن زياد الهلالي
19ـ حماد عجرد
20ـ صالح بن عبد القدوس
21ـ معن بن زائدة
22ـ ابن الراوندي
23ـ حماد الراوية
24ـ حماد بن الزبرقان
25ـ محمد بن عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط
26ـ إسحاق بن خلف
27ـ أبو حيان التوحيدي
28ـ عبد الكريم بن أبي العوجاء
29ـ أبو العلاء المعري
30ـ أبو زيد البلخي
31ـ ديك الجن
32ـ الوليد بن يزيد
33ـ عبد الكريم بن نويرة الذهلي
34ـ الجعد بن درهم
35ـ خالد بن عبد الله القسري
36ـ أبو طالوت
37ـ أبو شاكر
38ـ ابن أخي أبي شاكر
39ـ نعمان بن أبي العوجاء
40ـ ابن الأعدى الحريزي
41ـ ابن سيابة
42ـ سلم الخاسر
43ـ علي بن الخليل
44ـ علي بن ثابت
45ـ أبو عيسى الوراق
46ـ أبو العباس الناشئ
47ـ محمد بن أحمد الجبهاني
48ـ محمد بن عبيد الله
49ـ محمد بن عبد الملك الزيات
50ـ أنس بن أبي شيخ
51ـ أبو دلامة
52ـ علي بن عبيدة الريحاني
53ـ الحسين بن الصباح الإسماعيلي
54ـ منقذ بن عبد الرحمان الهلالي
55ـ حفص بن أبي وردة
56ـ يونس بن أبي فروة
57ـ عمارة بن حمزة
58ـ يزيد بن الفيض
59ـ جميل بن محفوظ
60ـ أبان بن عبد الحميد اللاحقي
61ـ علي بن ثابت
62ـ أبو العتاهية
63ـ علان الشعوبي
64ـ شريك القاضي
65ـ علي بن الخليل
66ـ جهم بن صفوان
67ـ أبو يحيى
68ـ أبو علي سعيد
69ـ أبو علي رجا
70ـ نرد أنبحت
71ـ زائدة بن معن بن زائدة
72ـ عمار ذي كناز الهمداني
73ـ مروان بن محمد (الخليفة الأموي).
74ـ أبو حفص الحداد
75ـ مطر بن أبي الغيث
76ـ الصيمري
77ـ أبو سعيد الحصيري
78ـ جرير بن حازم الأزدي
79ـ الثغوري
80ـ أبو إسحاق النصيبي
81ـ الشلمغاني
82ـ المغيرة بن سعيد
83ـ محمد بن زكريا الرازي
84ـ ابن ذر الصيرفي
85ـ الحسن بن الصباح
86ـ ابن أبي الوليد
87ـ الشيخ محمد عبدة الإمام (المصلح المصري الكبير).
هذا عن الأفراد الذين يضاف إليهم أُسَر كاملة: كالبرامكة، وآل سهل، أو فرق مذهبية كاملة: كالمعتزلة، وأصحاب الكلام، وكالفاطميين العبيديين أصحاب مصر.
والآن، بعد استعراض كل هذه الأسماء، التي قد نجد الكثير ممّا يفرّق بينها، ولا تجد شيئاً ممّا يجمعها؛ أظنّ من حقّك أن تتساءل عمّا تعني الزندقة والزنادقة. وهل هناك مذهب مهما جررت من أطرافه ووسعت فيه، يستطيع أن يضم هؤلاء جميعاً، ويبقى مع ذاك مذهباً واحداً، دون أن تسخر من التاريخ والمؤرّخين، ودون أن تشك، لا فيما تناولوا من موضوع الزندقة والزنادقة، بل من كل المواضيع التي تناولوها.
ستجد في هؤلاء الزنادقة، المشرك الوثني والمسلم الموحّد.
ستجد العربي الصليبة، والعربي المغموز النسب، والمولى، والفارسي.
ستجد الجاهلي، والمخضرم، ومَن عاش في ظل الإسلام.
ستجد الملحد الدهري، والثنوي، والشاك، والمتحيّر.
ستجد الماجن الخليع الراكض وراء لذّات الحياة، والزاهد المتعفّف الذي ترك الحياة ولذّاتها.
ستجد مَن يؤمن بالاثنين، ومَن ينكر الواحد.
ستجد مَن جعل مذهبه اللواط ونكاح المحارم، ومَن حرّم على نفسه حتى الزواج الذي حلّله الله ودعا إليه.
ستجد المفكّر صاحب الرأي، والهازل الذي لا يريد أن يفكّر أو يكون له رأي.
ستجد مَن تبع مزدك، ومَن قاتل مزدك.
كيف أصبح كل هؤلاء إذن أتباع مذهب واحد، هو الذي اصطلح على تسميته زندقة. وهم لو سألتهم لأنكر كل منهم صاحبه، وبرئ منه ولعن مذهبه.
وهكذا أراني سأتجاوز ما تعارف عليه الكتّاب في الزندقة من محاولة التمهيد لكتاباتهم، بالوقوف عند أصل الكلمة (زندا أوفستا) كتاب زرادشت، وتطوّرها بعد ذاك , فليس علمياً ولا مجدياً أن تحاول جمع ما لا يجتمع، ثم ترجعه، خلافاً لأبسط قواعد المنطق، إلى لفظ قديم لا صلة له مطلقاً بما تريده منه، ولا يحدّد شيئاً ممّا استعمل فيه.
أيّة صلة بين زندا أوفستا وبين بعض من رأينا، ممّن لا يؤمن بزرادشت ولم يسمع به ولا بكتابه، ومَن لم يعرف أنّ في الدنيا كان يعيش شخص اسمه زرادشت.
سأتجاوز إذن أصل اللفظ، وما كان يعنيه في البدء لأنتقل إلى ما كان الناس يفهمون منه، وما كانت السلطة تريد به، وما كان المؤلّفون يقصدون إليه، وهم يبررون عمل السلطة وأحياناً يسبقونه ويمهّدون إليه.
ولكن قبل أن أصل إلى ذلك الموضع، رأيت هؤلاء المؤلّفين يتحدثون عن زندقة وزنادقة في الجاهلية، محدّدين أشخاصاً وقبائل عرفوا بالزندقة.
ولهذا آثرت أن أبدأ من هنا. فزندقة الجاهلية أمر فيه طرافة تثير الفضول. فأنا لم أكن أعرف مثلاً أنّ في الجاهلية زنادقة. وإذا عرفت فأنا أجهل ماذا كانت تعني الزندقة عندهم، ولا العلاقة التي تربط هؤلاء بزنادقة الإسلام: فيم يلتقون و فيم يفترقون! وهل من سبيل إلى تحديد مذاهبهم واتجاهاتهم. وهل تعرّضوا أو بعضهم للقتل كما حصل ذلك في الإسلام؟!
الفصـل ا لثاني:
الزندقـة في الجاهليـة
1 - الزندقة وقريش:
عند الحديث عن أديان العرب في الجاهلية توقّفت طويلاً، وأنا أقرأ ما يذكره ابن قتيبة ويتابعه آخرون (1) عن الزندقة في قريش، والمجوسية أو الزندقة في تميم. فاللفظان، وألفاظ كثيرة أُخرى سنصادفها فيما بعد، يستعملها المؤرّخون المسلمون ويردّدونها في كتبهم، وهم لا يريدون غير الشيء نفسه وإن كان كلامهم هنا عن الزندقة في قريش والمجوسية في تميم؛ يشير إلى أنّ هؤلاء المؤلّفين يميّزون بين ديانتين جاهليتين مختلفتين لكل من قريش ومن تميم.
ويضيف ابن قتيبة، وكأنّه يجيب على سؤال حول مصدر الزندقة عند قريش أنّهم (أخذوها من الحيرة).
وأول ما ألاحظه هنا. أنّ الحيرة كانت نصرانية، وكان أهلها أو غالبيتهم نصارى كما هو معروف. فدورها، إذا قبلت أن يكون لها دور ديني في المحيط العربي، لن يتجاوز النصرانية ولن يتعدّاها.
لقد كانت عاصمة المناذرة على آلاف الكيلومترات من مكّة. وكانت قبائل عربية كثيرة أقرب من قريش ومكّة، إلى الحيرة وأوثق صلة بها وبأهلها. لكنّها لم تعرف الزندقة ولم تدن بها، وهي أولى باعتناقها من قريش التي كان اتصالها وخط رحلاتها إلى الشام واليمن. في الصيف إلى الأُولى، وفي الشتاء إلى الثانية. وليس بينهما الحيرة أو مكان قريب منها.
____________________
(1) المعارف لابن قتيبة طبعة سنة 1960 تحقيق الدكتور ثروت عكاشة ص621 والحور العين لنشوان بن سعيد تحقيق كمال مصطفى ط1972 ص136 والأعلاق النفيسة ط ليدن 1892 ص217.
كنت ترى في الحيرة، وعند ملوكها من المناذرة، وفود العرب من كل القبائل: تميم وغطفان وهوازن وبكر وتغلب وسواها. وقلّما رأيت فيها أو عند ملوكها وفوداً من قريش.
ترى حاجب بن زرارة، وأكثم بن صيفي، وحذيفة بن بدر، والحارث بن ظالم، والربيع بن زياد، وعامر بن مالك، وخالد بن جعفر، وقيس بن مسعود، والحوفزان بن شريك، وعمرو بن كلثوم، وغيرهم.
ولا ترى أحداً من سادات قريش وزعمائها، لا عبد المطلب، ولا أبا طالب، ولا أبا سفيان، ولا عتبة بن ربيعة، ولا الوليد ابن المغيرة، ولا أمية بن خلف، ولا مَن هو في منزلتهم، ولا مَن هو دونهم إلاّ في النادر القليل من المناسبات.
فأيّة صلة هذه التي يتحدث عنها المؤرّخون، أو أيّة زندقة هذه التي قطعت مسافة بين الحيرة ومكّة، دون أن تتوقّف أو تنزل في قبيلة من قبائل العرب المنتشرة على طول الطريق، وكأن طائرة حملتها من مطار الحيرة لتحط بها في مطار مكّة.
وكيف سنوفِّق بين زندقة قريش، وبين تحمّسها لدينها وتشدّدها في التمسّك به والدفاع عنه، حتى أطلقوا عليها وعلى بعض القبائل التي سلكت سبيلها اسم الحمس المأخوذ من الحماس أو الحماسة، أي التشدّد في الدين ورعايته والحفاظ عليه، وهو ما يتفق عليه المؤرّخون.
ثم ماذا يعني المؤرّخون بالزندقة، وهم يتحدثون عن زندقة قريش في الجاهلية؟!
حين يتحدث هؤلاء عن الزندقة في الإسلام. فإنّ تهم الكيد للعروبة والسعي لإعادة مجد فارس، ومحاولة هدم الإسلام، ترهقك من كثرة ما تتردّد عند أي واحد منهم، وهو يريد أن ينال من عدو له، أو مذهب يراه عدواً له، أو رأي يخالف ما ألّف واعتاد.
والآن، في حديثهم عن زندقة قريش، ماذا يريدون وأيّة تهمة سيوجّهونها لقريش، والزندقة هي الزندقة، قرشية كانت أم غير قرشية.
لا مجال للحديث عن الكيد للعروبة والسعي لإعادة مجد فارس، فهذه التهمة لا يمكن طبعاً إثارتها أو التعلّق بها هنا، ونحن في بطاح مكّة وبين رؤوس العرب وقادتها.
ولا مجال للحديث عن الإسلام ومحاولة هدمه؛ لأنّ الأمر يخص الجاهلية قبل أن يولد الإسلام، وربّما قبل أن يولد نبي الإسلام. فهذه التهمة ساقطة بالضرورة، ولا يمكن اللجوء إليها كما يفعلون عادةً حين يهاجمون مَن يسمّونهم الزنادقة في العصور الإسلامية.
ولا يمكن الحديث عن إلحاد قريش، وهي المتمسّكة بأوثانها، والمقاتلة عنها حتى مجيء الإسلام وانتصاره.
كما لا يراد بالزندقة، الكفر فهي غيره ولا تلازم بينهما، وإلاّ لكان العرب كلهم قبل الإسلام زنادقة، لا قريش وحدها. ولكان غير المسلمين من أتباع الديانات الأُخرى كلهم زنادقة أيضاً عند المسلمين؛ لأنّهم كلهم كفّار في نظرهم.
فماذا كانت زندقة قريش إذن؟!
هل كانت قريش مانوية تؤمن بالأصلين: النور والظلمة اللذين جاء بهما ماني، وبتعاليمه من تحريم النكاح وقطع النسل، وعدم ذبح الحيوان أو إيلامه.
لا أحد يقول بهذا ولا بما هو قريب منه، وقد ملأ نسلهم الأرض. كما كانت غاية الفخر عندهم أن ينحروا لمن ينزل عندهم ويضيفهم. بل إنّ الإنسان وهو كائن ذو روح لم يكن قتله إلاّ أمراً معتاداً كلما نشبت حرب أو ثار قتال، وما أكثر ما تنشب الحرب أو يثور القتال.
هل كانت قريش مزدكية آمنت بمزدك واعتنقت ما كان يدعو إليه من إباحة المال والنساء مثلاً، بعد ما تركنا الكيد للعروبة، والسعي لإعادة مجد فارس، ومحاولة هدم الإسلام والطعن بنبوّة محمد، وتركنا الإلحاد والكفر والمانوية التي تحرّم النكاح وذبح الحيوان.
أيمكن لأحدنا أن يتصوّر ذلك؟! ولكن هل ترك ابن قتيبة ومَن تبعوه من خيارٍ أمامنا غير الذي اختاروه لنا، جهلاً منهم وسوء تقدير لما يترتّب على كلامهم.
وأظن ابن حبيب (1) والثعالبي (2) كانا أدق وأوضح حين ذكروا أشخاصاً معيّنين من قريش وصفاهم بالزندقة.
وهؤلاء الأشخاص هم:
1 - أبو سفيان (قبل أن يسلم).
2 - الوليد بن المغيرة المخزومي (والد الصحابي خالد بن الوليد).
3 - العاص بن وائل السهمي (والد الصحابي عمرو بن العاص).
4 - عقبة ابن أبي معيط الأموي (والد الوليد بن عقبة بن أبي معيط).
5 - أُمية بن خلف الجمحي المقتول ببدر.
6 - نبيه ومنبه ابنا الحجاج السهميان المقتولان ببدر.
فحين ينحصر الأمر في أشخاص محدّدين: ستة أو سبعة أو أقل أو أكثر، فإنّ تفسير اعتناقهم الزندقة أو غير الزندقة سيكون أسهل، ولا يثير الصعوبات التي يثيرها الادعاء بنسبة قبيلة كاملة مثل قريش إلى الزندقة.
لكنّه سيثير على كل حال نفس السؤال الذي أُثير قبل قليل: ما هي طبيعة الزندقة التي اعتنقها هؤلاء الستة أو السبعة، أو الأقل أو الأكثر من سادات قريش ورجالها؟
هل كانوا من أتباع مزدك في شيوعية المال والنساء؟!
وأسفت ألاّ يكون في المكتبات شيء من مؤلّفات الوليد بن المغيرة، أو العاص بن وائل في الفرق والعقائد، ولا في كشف الظنون اسم واحد من مؤلّفاتهم، ولعلّها غرقت فيما غرق من كتبهم في العقائد والفلسفة وحرب الفجار، عند هجوم التتار على بغداد، وهو ما منعني من معرفة الوجه في زندقتهم، والفرق بينها وبين مجوسية تميم. وهل أنّ الزندقة في قريش تستحلّ نكاح المحارم كما يستحلّها المجوسية في تميم؟!
ومع ضياع مؤلّفات الوليد والعاص وأصحابهما. رأيت أن ألقى أحدهم وأسأله عن صحّة ما يقوله المؤلّفون عنهم. وقد فضّلت أن يكون لقائي مع الوليد فهو كبير القوم وشيخهم، وليس لي أن أتجاوزه بالسؤال من غيره.
وتوجهت إليه بالسؤال الذي حملته معي عن صحّة ما يزعمه المؤرّخون عنهم من نكاح البنات، كما اتهموا حاجب بن زرارة سيد تميم بذلك.
____________________
(1) المحبر لأبي جعفر محمد بن حبيب ت 245، رواية أبي سعيد السكري، تحقيق الدكتورة ايلزة شنيتر نشر المكتب التجاري بيروت ص161.
(2) لطائف المعارف لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي ت 429، تحقيق إبراهيم الأبياري وحسن كامل الصيرفي، نشر دار إحياء الكتب العربية ص104.
وما بدأت سؤالي حتى اربدّ وجهه وكان بجنبه سيف قاطع رأيت يده قد امتدت إليه فعرفت أيّة حماقة ارتكبت. وانسحبت مسرعاً قبل أن أندم على هذا اللقاء الذي لن ينفعني فيه، لو حصل المكروه - وقد كاد أن يحصل - لا ابن حبيب ولا ابن قتيبة، ولا جميع الذين كتبوا ممّن كذبوا عليهم.
وعلى كلٍّ، فإنّ ابن حبيب والثعالبي يقعان في خطأ آخر حين ينصّان على أنّ هؤلاء الزنادقة (تعلموا الزندقة من نصارى الحيرة) (1) فأنا أفهم أن يتعلّم الزنديق زندقته من الزنادقة، ويأخذ النصراني نصرانيّته من النصارى. أمّا أن يتعلّم الزنادقة زندقتهم من النصارى، فهذا ما لا أفهمه ولا أظن أحداً غيري يفهمه. فالمرء يأخذ عقيدته عادةً أو يتعلّمها إن لم يكن قد نشأ عليها، من أصحابها لا من الغرباء عنها؛ الإسلام من المسلمين، والمسيحية من المسيحيين، والزندقة من الزنادقة. وأحسب هذا من الأُمور التي لا مجال للنقاش فيها.
أمّا أن يأخذ المسيحي مسيحيّته من المسلم، والزنديق زندقته من المسيحي، فهذا ما لا نجد جوابه إلاّ عند ابن حبيب.
ولو تجاوزنا عن ذلك فكيف صبأ هؤلاء، وتركوا دينهم ودين آبائهم فتزندقوا، ولم تعترضهم قريش ولم تمسّهم بسوء، ولم تمنعهم أو تؤذهم كما فعلت مع محمد. ولم تعادِ وتقاطع عشائرهم كما عادت وقاطعت عشيرة محمد، خصوصاً وأنّ ما يدعون إليه من إشاعة المال والنساء كما تذهب إلى ذلك المزدكية، أجلب للخطر والعار وأحرى أن يلغي نفوذ قريش وهيبتها بين قبائل العرب.
أليست الزندقة رفضاً للأوثان وإنكاراً لعبادتها؟
وعلى ماذا قامت دعوة محمد، أوّل ما قامت، غير رفض الأوثان وإنكار عبادتها واستبدال عبادة الله وتوحيده بها.
فلِم تشدّدت قريش هنا وتسامحت هناك؟!
هذا هو السؤال. إلاّ أن يكون المؤرّخون أخطأوا في حديثهم عن زندقة قريش. أو أن يكونوا قصدوا بالزندقة، غير ما نعرف. وليس هذا ممّا نؤاخذ عليه، في أيّة حال.
____________________
(1) المحبر لابن حبيب ص161 ولطائف المعارف للثعالبي ص102.
2 - المجوسيّة في تميم:
لا أدري من هذا الذي حدّد لأول مرة أديان العرب في الجاهلية، ووزّعها بين قبائلهم، أو وزع قبائلهم بينها؟ وكيف وصل هذا التوزيع مؤرّخينا فأخذوا به وردّدوه وتداولوه في كتبهم، دون تفكير فيه أو محاولة لتصحيح ما كان بيّن الخطأ منه.
كيف قبلوا ونقلوا مثلاً أنّ تميماً: هذه القبيلة التي إذا غضبت حسبت الناس كلهم غضابا، يمكن أن تدين بالمجوسية أو تدنو منها، وهو رأي مؤرّخينا حين يعرضون لأديان العرب في الجاهلية ويخوضون في حديثها.
يقول ابن قتيبة (1) ونشوان (2) وابن رستة (3) : (وكانت المجوسية في تميم) ثم يضيفون: (منهم زرارة بن عدس وابنه حاجب بن زرارة وكان تزوج ابنته وندم …) كأنّهم بذلك يريدون أن يؤكّدوا ما يقولون عن تميم.
فمجوسية تميم إذن هي المزدكية على وجه التخصيص من بين مذاهب الفرس الأُخرى. فهذا المذهب وحده خلافاً لتلك المذاهب، هو الذي يقوم على إباحة النساء وتحليل المحارم من بنت وغير بنت، وهو كما سترى ليس من المجوسية في شيء.
وما أظنّني، منذ مدة قد تكون طويلة، ضحكت من شيء قدر ضحكي من هذا الغباء الذي يريد أن يكون علماً، وهو لن يكون ذلك، حتى لو ألبسوا صاحبه ألف جبّة، ووضعوا على رأسه ألف عمامة.
وتذكّرت جريراً وأسفت ألاّ يكون العمر قد امتد به حتى يقرأ كتاب ابن قتيبة، فيستغني بما ورد فيه عن حاجب وفعلته مع ابنته دختنوس عن كل ما سواه ممّا هجا به الفرزدق.
ماذا كان سيجد أوجع وأقسى وأهدم لمجد الفرزدق ومجد أهله وعشيرته من أن يكون أحد مفاخره الكبيرة: سيد دارم وسيد تميم كلها قد نكح ابنته.
إذن لن يبخل على ابن قتيبه بقصيدة مديح من عالي شعره، وقد جنّبه الكثير من السهر والجهد والتعب وهو يقارع الفرزدق ويهاجيه، ويفتّش عن مثالب قومه من بني دارم.
أين يقع الهجاء بيوم تهزم فيه بنو دارم، يقابله يوم أو أيام ينتصرون فيها، كما يجري لجميع قبائل العرب، في جنب نكاح سيّدهم لابنته، وهو ما لم يعرفه العرب.
____________________
(1) المعارف، تحقيق الدكتور ثروت عكاشة، ط 1960 ص621.
(2) الحور العين: ص136.
(3) الأعلاق النفيسة، ط ليدن 1892 ص217.
لا يوم رحرحان ولا شعب جبلة، ولا غيرهما من الأيام التي هزمت فيها بنو دارم، تعدل فضيحة الفرزدق في عميد قومه حاجب الذي لم يعرف العرب فداءً أغلى من فدائه، أي هجاء أمض وأقطع للفرزدق ممّا فعله حاجب مع ابنته؟!
ولكن إذا كان جرير لم يمتد به العمر ليقرأ (معارف) ابن قتيبة فإنّ ابن قتيبة لا بد أنّه بلغه شعر جرير وسمعه وقرأه وهو يهجو دارماً، ويذكر في بعضه دختنوس هذه، ولكنّه لم يشر من قريب أو بعيد إلى ما وصمها به ابن قتيبة. وما أظن جريراً الذي أقذع وتجاوز الحد في هجاء الفرزدق، سيغفل عن هذا ولا ما يكون دونه، وهو قد مزق عرض جعثن أخت الفرزدق، وهي تميمية حنظلية مثله لن يسلم هو، لا الفرزدق وحده، من العار لو صحّ ما نسبه إليها، اسمع إليه وهو يقول:
أو دختنوس غداة حز قرونها |
ودعت بدعوة ذلة وثبور |
فهل سمعت شيئاً ممّا يعيب المرأة؟ هل سمعت غير أنّها جزّت شعرها حزناً على أبيها الذي قُتل في المعركة كأيّة امرأة عربية حين يبلغها مقتل أبيها، وهو سيّد القوم وفارسهم.
ولنترك جريراً التميمي الحنظلي الذي قد يكون كفّه عن ذلك نسب واحد يجمعه بدختنوس وحاجب، وهو ما أقطع بخلافه كما ذكرت قبل قليل، فما بال الشعراء الآخرين من غير تميم سكتوا عن هذه الحادثة، فلم يتعلقوا بها ولم يرددوها في شعرهم وهم يهاجمون الفرزدق وغير الفرزدق من شعراء تميم.
وبعد جرير والفرزدق وحديث الشعر والشعراء، أعود مرة أُخرى إلى رواية ابن قتيبة لأسأل: مَن تكون دخنتوس هذه التي جعلها صاحب المعارف، بنتاً لحاجب بن زرارة، ونسب إليها وإلى حاجب ما أستنتج منه المجوسية في تميم؟
دختنوس هذه باتفاق المؤرّخين لم تكن بنت حاجب كما ادعى، بل بنت أخيه لقيط بن زرارة سيد تميم وفارسها يوم الشعب، وكانت متزوّجة من عمرو بن عمرو بن عدس الدارمي أحد فرسان تميم المعدودين.
هذا ما يقوله أبو عبيدة معمر بن المثنى المعروف بتطلبه لمثالب العرب في النقائض (1) ومحمد بن حبيب في المحبر (2) وابن عبد ربه في العقد الفريد (3) وأبو الفرج في الأغاني (4) وبين هؤلاء مَن هو أسبق من ابن قتيبة، ومَن عاصره، ومَن جاء بعده. لم ينسبها لحاجب منهم أحد ولم يذكر الحادثة منهم أحد.
ويؤكّده ما ينقله هؤلاء المؤرّخون ومؤرّخون غيرهم من الذين كتبوا عن أيام العرب، ومنها يوم شعب جبله بين تميم وذبيان وبين عامر وعبس أنّ لقيطا قال في ذلك اليوم:
يا ليت شعري كيف دختنوس |
إذا أتاها الخبر المرموس |
وما قالته دختنوس نفسها وقد وردها مقتل أبيها وضرب بني عبس له وهو قتيل:
ألا يا لها الويلات ويلة مَن بكى |
لضرب بني عبسٍ لقيطاً وقد قضى |
ولأترك هذا كله، فكيف تكون المجوسية واستحلال المحارم في تميم، ولم تعرف قبيلة من قبائل العرب بوأد البنات، كما عرفت تميم التي انتشر الوأد فيها اتقاءً للعار وهرباً ممّا تجرّه البنت عليها، وهم معرّضون للغزو والغارة والنصر والهزيمة، وليس أجلب للعار ممّا يمكن أن يحصل للبنت في أثناء ذلك.
لقد جاء الإسلام وصعصعة بن ناجية المجاشعي الدارمي جد الفرزدق، ومن رهط حاجب، قد أحيى مئات الموءودات وكان ذلك من أكبر مفاخر الفرزدق التي انفرد بها وهو يهاجي جريراً.
فلمَ الوأد إذن وقتل البنت وهي طفلة لم يصدر عنها ما يشين، إذا كانت تميم نفسها تبيح نكاح البنت ولا تجد فيه عاراً، وإذا كان سيّدهم حاجب بن زرارة قد استحل ذلك ونكح هو ابنته؟!
لقد حرم قيس بن عاصم المنقري التميمي الخمر على نفسه؛ لأنّه فيما يروى غمز ابنته وهو سكران، فحين أُخبر بما فعل أقسم ألاّ يذوق الخمر بعدها، وكان ممّن حرّمها على نفسه في الجاهلية.
____________________
(1) النقائض لأبي عبيدة، ط ليدن 1907 ج2 ص665.
(2) المحبر: ص436.
(3) العقد الفريد لابن عبد ربّه، تحقيق محمد سعيد العريان ج6 ص10.
(4) الأغاني، ط دار الكتب ج11 ص144.
ثم لماذا حاجب وحده فلا يذكر ابن قتيبة آخر أو آخرين من تميم شاركوه فعله فتزوّجوا بناتهم، ما دامت تميم مجوسية تستحل نكاح البنات وتقبله ولا تتحرّج منه، سابقة بمئات السنين بعض مَن يسمّونهم طوائف الغلاة والقرامطة، الذين يتهمهم أعداؤهم باستحلال المحارم ونكاح البنات، وينسبون إليهم لتثبيت التهمة، أبيات يرددونها، أذكر منها بيتين يتعلقان بموضوعنا هذا هما:
وكيف حللت لهذا الغريب |
وصرت محرمـة للأبِ |
|
أليس الغراس لمن ربّه |
وروّاه في عامه المجدبِ |
وإذا كنت لا أفهم هذا كله، فمن الأحرى ألا أفهم لماذا ندم حاجب على نكاح ابنته كما يقول ابن قتيبة، وهو مجوسي لم يخرج على دينه فيما فعله ولم يخالف تعاليمه.
وأخيراً فأراني مضطراً أن أعود إلى النصوص التي تذهب إلى مجوسية تميم، وأقارن بينها مبتدئاً بنص ابن قتيبة الذي يقول: (وكانت المجوسية في تميم، منهم: زرارة بن عدس التميمي وابنه حاجب بن زرارة، وكان تزوّج ابنته ثم ندم. ومنهم: الأقرع بن حابس وكان مجوسياً، وأبو سود جد وكيع بن حسان (1) كان مجوسياً).
وإليك نصّ ابن رسته (وكانت المجوسية في تميم، منهم: زرارة بن عدس التميمي، وابنه حاجب بن زرارة، وكان تزوّج ابنته ثم ندم، ومنهم الأقرع بن حابس وكان مجوسياً، وأبو سود جد وكيع بن حسان كان مجوسياً).
وهذا أخيراً نص نشوان بن سعيد: (وكانت المجوسية في تميم، منهم: زرارة بن عدس التميمي وابنه حاجب بن زرارة وكان تزوج ابنته ومنهم الأقرع بن حابس وكان مجوسيا وأبو سود جد وكيع بن حسان كان مجوسيا).
فهل وجدت أي فرق بين ثلاثة نصوص لثلاثة مؤرّخين مختلفين في ثلاثة عهود مختلفة متباعدة.
ألم يهتد أحدهم إلى ما يخالف الآخر في شيء: إضافة أو حذفاً أو تغييراً في عرض وترتيب المعلومات بتقديم بعض أو تأخير بعض باستثناء (ندم) التي لم ترد عند نشوان، وما أظنها سقطت إلاّ عن سهوٍ من الناسخ.
أيّ تاريخ هذا التي تستطيع أن تستغني فيه عن كل المصادر بمصدر واحد؛ لأنّها كلها تنقل عنه وتعتمد عليه. لم تبحث ولم تناقش ولم تراجع ولم تستقل برأي. فعلى كثرة ما ترى في هوامش الكتب أحياناً من أسماء مصادر، قد توهمك بأنك أمام حقيقة لا مجال للشك فيها لكثرة الناقلين أو المنقول عنهم، فإنّك لا تنقل في الواقع إلاّ عن واحد. وليس الباقون إلاّ نقلة عنه - مثلك - سبقوك في الزمن وتأخّرت.
____________________
(1) الفاتك المشهور، وقاتل قتيبة بن مسلم بخراسان في خلافة سليمان بن عبد الملك.
الفصل الثا لث:
الزندقـة فـي الإسلام
وبعد حديث الزندقة في الجاهلية الذي أعترف أنّي لم أصل فيه إلى شيء، غير مجموعة من علامات الاستفهام التي ستبقى تفتّش عن جواب حتى يأذن الله به.
أصلُ الآن إلى حديث الزندقة في الإسلام، حيث يختلط الفكر باللافكر، والزهد بالمجون، والإلحاد بمذهب الاثنين.
والعربي الصليبة بالشعوبي المتعصب ضد العرب، وحامل السيف والرمح بحارس بيت النار في معابد المجوس.
و ما أظنني سأكون أسعد حظاً في الوصول إلى نتائج مُرضية مع هذا الخليط الغريب، ممّا اصطلح على تسميته بالزندقة، وإن كان هذا لا يعفيني ولا يعفي غيري من المضي في الحديث عنها، حتى لو لم أتجاوز علامات الاستفهام التي أشرت إليها آنفاً؛ بل ربّما كان ذلك أحرى أن يغري بمحاولة، قد تلقي بعض الضوء في طريقٍ ظلّ شديد الظلام فترة غير قصيرة، ونقطة ضوء فيه ليست عديمة الفائدة إن كانت قليلة الغناء.
ولعلّ ممّا يساعد في ذلك أن نعرف متى استعمل هذا اللفظ في الوجوه، التي مثلت الزندقة عند المسلمين أو بعضها في الأقل، ومن هناك نستطيع أن نتابع تطوّره واتساعه ليتناول غيرها من الوجوه؛ إذ ليس من المعقول أن يطلق اللفظ ابتداء ليدل على ما أصبح يدل عليه، أو ما أريد منه أن يدل عليه.
ليس من المعقول أن يطلق اللفظ ابتداء على الملحد واللواط ومستحل المحارم والمجاهر بشرب الخمر ومعتقد الاثنين ومنكر النبوّات ومحرم الزواج و … و (1)
فمتى استعمل هذا اللفظ؟
هنا أيضاً لا تمدّنا المصادر بما يحل إشكالنا أو يساعد على حلّه. ولم أجد بين الذين تعرّضوا للموضوع وكتبوا فيه مَن تجاوز (الزندافستا) (2) الزرادشتي، أو اشتقاقات منسوبة إلى عصور ليست أقرب من الزندافستا، الذي قفز عبر الزمن ليحط في القرن الثاني الهجري، محمّلاً بكل تلك الآثام التي عرفها ذلك القرن والقرون التالية له.
____________________
(1) ويمكنك أن تضيف إلى كل أولئك: مَن ينتقص الصحابة أو طعن في عدالتهم عند أصحاب الحديث و(من طلب الدين بالكلام) عند أبي يوسف. والمعتزلة عنده أيضاً، ربّما للسبب السابق والجهمية عند الأصمعي. ومَن يشرب الخمر ويضرب بالطنبور كما يذكر صاحب العقد الفريد ج4 ص105 والعبيديين الفاطميين. وحتى الإمام الشيخ محمد عبدة لم يسلم من الاتهام بالزندقة هو وجماعة من أصحابه، كما يذكر الدكتور محمد حسين هيكل في (حياة محمد) ط1 القاهرة 1354هجري ص15.
(2) أنظر في ذلك ص 75 وما بعدها من كتاب عبد الله بن المقفّع للسيد محمد غفراني الخراساني، نشر الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة 1965.
لقد كانت بعض وجوه الزندقة معروفة قبل الإسلام وبعده، لكنّها كانت تسمّى بأسمائها ولم تكن الزندقة بين هذه الأسماء.
كان الكفر معروفاً في الجاهلية ومعروفاً في الإسلام.
وكان الزنا واللواط معروفاً في الجاهلية ومعروفاً في الإسلام.
وكانت الخمر ومعاقرتها والتمدّح بشربها معروفاً في الجاهلية ومعروفاً في الإسلام.
لكنّها كانت كفراً وزنا ولواطاً وخمراً. هذه أسماؤها في الجاهلية وهي أسماؤها في الإسلام الذي فرض على ارتكابها عقوبات محدّدة، ولم يكن هناك ما يسمّى زندقة.
هذا يزيد بن معاوية المتوفّى عام 64 والذي ارتكب من الذنوب والمعاصي ما يخرج به على كل دين لا الإسلام وحده لم أجد مَن وصفه بالزندقة. لقد وصفوه بأنّه: فاسق فاجر وحتى كافر لكنّه لم يوصف في عصره بالزنديق، وما أظن ذلك إلاّ لأنّ اللفظ كتهمة منافية للإسلام لم يكن قد عرف بعد. لا إشفاقاً على يزيد، ولا لأنّ الأفعال التي ارتكبها لا توجب له هذا الوصف، الذي لحق في زمن تال من لم يرتكب بعض ما ارتكبه.
وهكذا يمر القرن الأوّل ولم أعرف مَن استعمل لفظ الزنديق في واحد من الوجوه التي شملها فيما بعد.
وأحسب أنّ أوّل إشارة إلى الزندقة كفكر أو سلوك مخالف للإسلام جاءت في بدايات القرن الثاني مع الوليد بن يزيد بن عبد الملك الخليفة السيئ الصيت.
فأبو الفرج يورد اللفظ في موضعين عند الحديث عنه أما أوّلهما فهذا نصّه:
(وكتب - يعني هشام بن عبد الملك - إلى الوليد: ما تدع شيئاً من المنكر إلاّ أتيته وارتكبته غير متحاش ولا مستتر فليت شعري ما دينك؟! أعلى الإسلام أنت أم لا؟! فكتب إليه الوليد بن يزيد ويقال بل قال ذلك عبد الصمد بن عبد الأعلى، ونحله إيّاه:
يا أيّها السائل عن ديننا |
نحن على دين أبي شاكرِ |
|
نشربها صرفاً وممزوجة |
بالسخن أحياناً وبالفاتـرِ |
فغضب هشام على ابنه مسلمة وقال: يعيرني بك الوليد وأنا أرشحك للخلافة فالزم الأدب واحضر الصلوات وولاّه الموسم سنة سبع عشرة ومائة، فأظهر النسك وقسم بمكّة والمدينة أموالاً فقال رجل من موالي أهل المدينة:
يا أيّها السائل عن ديننا |
نحن على دين أبي شاكرِ |
|
الواهب البزل بأرسانها |
ليس بزنديقٍ ولا كافـرِ (1) |
هذا أحد النصّين وفيه كما ترى يرد لفظ الزنديق، وفيه كما ترى أيضاً ما يحدّد بعض ملامحه بربطه بالكافر الذي لا يدين بالإسلام.
أمّا النص الثاني فصريح لو صح، في تحديد الوجه الذي بدأ يعنيه اللفظ وهو المانوية.
فيروي صاحب الأغاني عن العلاء بن بندار أنّه قال: (كان الوليد زنديقاً وكان رجل من كلب يقول بمقالته مقالة التنويه، فدخلت على الوليد يوماً وذلك الكلبي عنده وإذا بينهما سفط قد رفع رأسه عنه فإذا ما يبدو منه حرير أخضر، فقال: أدن يا علاء، فدنوت فرفع الحريرة فإذا في السفط صورة إنسان، وإذا الزئبق والنوشادر قد جعلا في جفنه فجفنه يطرف كأنّه يتحرك فقال: يا علاء هذا ماني لم يبتعث الله نبياً قبله ولا يبتعث نبياً بعده، فقلت: يا أمير المؤمنين اتق الله ولا يغرنّك هذا الذي ترى عن دينك. فقال له الكلبي: يا أمير المؤمنين ألم أقل لك: إنّ العلاء لا يحتمل هذا الحديث، قال العلاء: ومكثت أياماً ثم جلست مع الوليد على بناءٍ كان بناه في عسكره يشرف به والكلبي عنده إذ نزل من عنده وقد كان الوليد حمله على برْذَون هملاج أشقر من أفْرِهَ ما سُخِّرَ، فخرج على بِرْذَونِه ذلك فمضى به في الصحراء حتى غاب عن العسكر، فما شعر إلاّ وأعراب قد جاؤوا به يحملونه منفسخة عنقه ميتاً وبِرْذَونَه يقاد حتى أسلموه. فبلغني ذلك، فخرجت متعمداً حتى أتيت أولئك الأعراب، وقد كانت لهم أبيات بالقرب منه في أرض البَخْراء لا حجر فيها ولا مدر، فقلت لهم: كيف كانت قصة هذا الرجل؟ قالوا: أقبل علينا على بِرْذَون، فو الله لكأنّه دُهْن يسيل على صفاةٍ من فَراهَتِه، فعجبنا لذلك، إذ انقضّ رجل من السماء عليه ثياب بيض فأخذ بضَبْعَيْه فاحتمله ثم نكسه وضرب برأسه الأرضَ فدقَّ عنقه، ثم غاب عن عيوننا، فاحتملناه فجئنا به (2) .
وأنا أشك في هذه الرواية لأسباب منها: أنّ ما هو معروف من أخلاق الوليد ومجونه وانغماسه في الملذّات، يتعارض تماماً مع ما كان يدعو إليه ماني من نسك وزهد ودعوة إلى عدم الزواج وقطع النسل.
____________________
(1) الأغاني طبعة دار الكتب ج7 ص4.
(2) الأغاني ج7 ص72 - 73.
ومنها أنّ شخصاً مثل هذا الكلبي الذي لا يشاركه أحد مجلسه مع الخليفة الوليد، ويلعب في حياته هذا الدور ويضلّه عن سبيل الإسلام إلى دين آخر، وهو يعرف العلاء معرفة تامة كما يظهر من الرواية. أفمن المعقول ألاّ يعرفه العلاء ولا يذكر اسمه ويكتفي في كل موضع يريد أن يذكره فيه بأنّه رجل من كلب أو الكلبي، مع أنّه رآه أكثر من مرة عند الخليفة.
ومنها أنّ ماني نفسه الذي يدين بما جاء به الوليد وهذا (الكلبي) يعترف بنبوّة عيسى. ودينه (المانوية) مزيج من النصرانية والمجوسية، فليس للوليد ولا لغيره أن يقول (لم يبتعث الله نبيّاً قبله …) إذا كان يدين حقاً أو يعرف ملّة ماني.
وأخيراً فإنّ هذه الرواية، خصوصاً في نهايتها، أشبه بالأساطير التي لا يمكن قبولها والاطمئنان إليها؛ ولهذا تحفّظت عليها منذ البداية بـ (لو صح).
على أنّ شكّي في الرواية لا ينفي أنّ هذا اللفظ قد بدأ تداوله في ذلك التاريخ أو تاريخ قريب منه، مع توسّع العرب بالفتح واختلاطهم بالفرس واطلاعهم على ما كانوا يدينون به، وانتقال بعض ذاك إليهم بسبب الاختلاط.
وممّا سبق، يظهر بوضوح ارتباط الزندقة في الأصل بأديان الفرس القديمة. ومن هنا وجب الإلمام ولو سريعاً بهذه الأديان، لمعرفة العلاقة بين الاثنين، ثم افتراق الزندقة وتوسّع مدلولها الذي شمل فيما بعد، ما لا علاقة له بتلك الأديان بل وما خالفها وعارضها.
ولنبدأ بأوّل هذه الأديان.
الفصـل ال رابع:
المجوسيّة
وهي أقدم ما عرف من مذاهب الفرس، وقد ورد ذكر المجوس في القرآن الكريم إلى جانب اليهود والنصارى والصابئة في سورة الحج:
( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ) .
وهم كما يظهر من الآية الكريمة ليسوا مشركين، ويعتبرهم المسلمون ممّن لهم كتاب أو شبهة كتاب (1) .
كما أنّهم ليسوا من القائلين بالاثنين، وهذا ما يبدو بوضوح من الشهرستاني في الملل والنحل حيث يعالجهم في فصل خاص، ويجعل للثنوية فصلاً آخر خاصاً بهم (2) .
ومن شعائر المجوس تعظيم النار وبناء البيوت لها.
وأهم مذاهبهم الزرادشتية (أتباع زرادشت) التي غلبت على سائر مذاهب المجوسية الأُخرى حتى أنّك لتستطيع، مع شيء من التجوز، أن تعتبر الزرادشتية هي الممثّلة للمجوسية، وهي المقصودة حين يجري الكلام عن المجوس والمجوسية.
ولا يعنيني أن يكون زرادشت من نسل نوشهر الملك أو أنّه من أهل فلسطين، كان خادماً لبعض تلامذة أرميا النبي فكذب عليه وخانه فأصابه البرص ولحق بأذربيجان. فأنا لا أريد أن أترجم له وما يعنيني هنا تعاليمه التي أتى بها أو التي تناقلها المسلمون، ومدى علاقتها بما اصطلح عليه بالزندقة.
يقول صاحب الملل والنحل: (وكان دينه عبادة الله والكفر بالشيطان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجتناب الخبائث) (3) .
هذه إذن هي تعاليم زرادشت تاركاً ما يذكره المؤلّفون عن المجوسية ممّا لا علاقة له بالزندقة، وإنّما بقضايا أُخرى تتصل بالسياسة وبغير السياسة من شؤون الحياة.
____________________
(1) الملل والنحل للشهرستاني ج1 ص208، والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج1 ص197.
(2) الملل والنحل ج1 ص233.
(3) الملل والنحل ج1 ص237.
الفصل ال خامس:
المانويّـة
أصحاب ماني الذي ظهر في زمان سابور بن اردشير. كان يقول بنبوّة عيسى ابن مريم، ودينه مزيج من النصرانية والمجوسية.
اتبعه سابور أوّلاً وترك المجوسية، لكنّه عاد إليها فيما بعد وقتل ماني وأتباعه. ويقال إنّ الذي تولّى ذلك بهرام بن هرمز بن سابور، أو بهرام بن بهرام.
(وفي أيام ماني هذا - كما يقول المسعودي - (1) ظهر اسم الزندقة الذي إليه أضيف الزنادقة، وذلك أنّ الفرس حين أتاهم زرادشت بن اسبيمان بكتابهم المعروف بالبستاه باللغة الأُولى من الفارسية وعمل له التفسير وهو الزند.. وكان الزند بياناً لتأويل المتقدم المنزل، وكان مَن أورد في شريعتهم شيئاً بخلاف المنزل الذي هو البستاه وعدل إلى التأويل الذي هو الزند قالوا: هذا زندي فأضافوه إلى التأويل، وأنّه منحرف عن الظواهر من المنزل إلى تأويل هو بخلاف التنزيل، فلمّا أن جاءت العرب أخذت هذا المعنى من الفرس وقالوا زنديق، وعرّبوه والثنوية هم الزنادقة …)
أمّا الخوارزمي في مفاتيح العلوم (2) فينسب كتاب الزند - تأويل الابستا - إلى مزدك ويربط الزندقة به وبأصحابه.
ولقد أورد الأُستاذ غفراني في كتابه عبد الله بن المقفع الآراء المختلفة في لفظ زنديق (3) لمَن أراد الزيادة.
ويذكر المؤلّفون أنّ تعاليم ماني كانت تقوم على ترك الكذب والقتل والسرقة والزنا والبخل والسحر وعبادة الأوثان وقتل ذي الروح أو أذاه.
هذا من ناحية سلوك الإنسان في حياته.
أمّا خارج هذا فإنّ المانوية تقوم على الأصلين الأزليين: النور والظلمة وأنّ العالم مصنوع ومركّب منهما.
____________________
(1) مروج الذهب ج1 ص275.
(2) مفاتيح العلوم للخوارزمي ص25 - 26.
(3) عبد الله بن المقفّع ص 75 وما بعدها.
الفصـل ا لسـادس:
المزدكيّـة
وهم أتباع مزدك الذي ظهر في أيام الملك قباذ ودعاه إلى دينه فأجابه. وحين تملك كسرى انوشروان فتك بمزدك والمزدكية، وقطع رؤوسهم وأعاد الناس إلى المجوسية.
وليس بين المزدكية والمانوية كبير اختلاف فيما يخص تركيب العالم من أصلين اثنين: النور والظلمة.
لكن الاختلاف الكبير يخص الجانب السلوكي من حياة الإنسان، ففي حين تقوم المانوية على النسك وقتل الشهوات والدعوة إلى قطع النسل تقوم المزدكية على شيوعية المال والنساء.
ومن هذا ترى أنّ ما بين الاثنين في هذا الجانب أكثر من مجرّد اختلاف، وإنّما هو العكس تماماً.
هذه هي أهم مذاهب الفرس القدماء، ثلاثة: المجوسية والمانوية والمزدكية. لا يجوز الخلط بينها والحديث عن أحدها وكأنّه يمثّلها كلها، إلاّ فيما يخص الأصلين الأزليين للعالم، الذي تشترك فيه المانوية والمزدكية، مع اختلافهما أو تعارضهما فيما عدا ذاك ممّا يخص سلوك الإنسان حسب ما قدّمنا.
ولم يفت المؤلّفين المسلمين أن يميّزوا بينهما، كما يتجلّى ذلك فيما كتبه: الطبري والمسعودي وابن النديم وابن حزم والشهرستاني.
أمّا البغدادي في الفرق بين الفرق، فيميّز أحياناً ويخلط أحياناً، فهو لا يثبت على رأي يمكن اعتماده والركون إليه، مع نبرة حادة هي سلاحه دائماً عندما يتعرّض لخصومه: مسلمين كانوا أم غير مسلمين.
فعلى أيٍّ من أتباع هذه المذاهب الثلاثة أطلق لفظ الزنادقة كجريمة يفرض على مَن يرتكبها أقسى أنواع العذاب؟
أمّا المجوس فقد لاحظنا أنّ أحداً من المؤلّفين لم يطلق عليهم هذا اللفظ، بل إنّ الخليفة العباسي المأمون ينفيه عنهم بكل وضوح في محاورة ينقلها لنا ابن النديم.
قال أبو يوسف أيشع القطيعي النصراني في كتابه في الكشف عن مذاهب الحرنانيين المعروفين في عصرنا بالصابة: إنّ المأمون اجتاز في آخر أيامه بديار مضر، يريد بلاد الروم للغزو، فتلقّاه الناس يدعون له، وفيهم جماعة من الحرنانيين، وكان زيّهم إذ ذاك لبس الأقبية، وشعورهم طويلة بوفرات كوفرة قرة جد سنان بن ثابت، فأنكر المأمون زيّهم، وقال لهم: مَن أنتم من الذمّة؟ فقالوا: نحن الحرنانية! فقال: أنصارى أنتم؟ قالوا لا! قال فيهود أنتم؟ قالوا لا! قال فمجوس أنتم؟ قالوا لا! قال لهم أفلكم كتاب أم نبي؟ فمجمجوا في القول. فقال لهم: فأنتم إذن الزنادقة، عبدة الأوثان، وأصحاب الرأس في أيام الرشيد والدي! وأنتم حلال دماؤكم، لا ذمّة لكم! فقالوا: نحن نؤدّي الجزية! فقال لهم إنّما تؤخذ الجزية ممّن خالف الإسلام من أهل الأديان الذين ذكرهم الله عزّ وجلّ في كتابه، ولهم كتاب وصالحه المسلمون عن ذلك، فأنتم ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء، فاختاروا الآن أحد أمرين: إمّا أن تنتحلوا دين الإسلام أو ديناً من الأديان التي ذكرها الله في كتابه، وإلاّ قتلتكم عن آخركم! فإنّي قد أنظرتكم إلى أن أرجع من سفرتي هذه، فإن أنتم دخلتم في الإسلام أو في دين من هذه الأديان التي ذكرها الله في كتابه، وإلاّ أمرت بقتلكم واستئصال شأفتكم! ورحل المأمون يريد بلد الروم، فغيّروا زيّهم، وحلقوا شعورهم، وتركوا لبس الأقبية، وتنصّر كثير منهم، ولبسوا زنانير، وأسلم منهم طائفة، وبقي منهم شرذمة بحالهم، وجعلوا يحتالون ويضطربون حتى انتدب لهم شيخ من أهل حران فقيه، فقال لهم قد وجدت لكم شيئاً تنجون به وتسلمون من القتل، فحملوا إليه مالاً عظيماً من بيت مالهم، أحدثوه منذ أيام الرشيد إلى هذه الغاية، وأعدوه للنوائب. وأنا أشرح لك، أيّدك الله، السبب في ذلك، فقال لهم: إذا رجع المأمون من سفره، فقولوا له: نحن الصابئون! فهذا اسم دين قد ذكره الله جل اسمه في القرآن، فانتحلوه فأنتم تنجون به. وقضى أنّ المأمون توفّى في سفرته تلك بالبذندون، وانتحلوا هذا الاسم منذ ذلك الوقت؛ لأنّه لم يكن بحران ونواحيها قوم يسمون بالصابة، فلما اتصل بهم وفاة المأمون ارتد أكثر مَن كان تنصّر منهم، ورجع إلى الحرنانية، وطوّلوا شعورهم حسب ما كانوا عليه قبل مرور المأمون بهم، على أنّهم صابئون، ومنعهم المسلمون من لبس الأقبية؛ لأنّه من لبس أصحاب السلطان، ومن أسلم منهم لم يمكنه الارتداد خوفاً من أن يقتل فأقاموا متستّرين بالإسلام، فكانوا يتزوّجون بنساء حرانيات، ويجعلون الولد الذكر مسلماً، والأنثى حرنانية، وهذه كانت سبيل كل أهل ترعوز وسلمسين القريتين المشهورتين العظيمتين بالقرب من حران، إلى منذ نحو عشرين سنة، فإنّ الشيخين المعروفين بأبي زرارة وأبي عروبة علماء شيوخ أهل حران بالفقه، والأمر بالمعروف، وسائر مشايخ أهل حران وفقهائهم، احتسبوا عليهم، ومنعوهم من أن يتزوّجوا بنساء حرانيات، أعني صابئات، وقالوا لا يحل للمسلمين نكاحهم؛ لأنّهم ليسوا من أهل الكتاب.
وبحران أيضاً منازل كثيرة إلى هذه الغاية، بعض أهلها حرنانية ممّن كان أقام على دينه في أيام المأمون وبعضهم مسلمون، وبعضهم نصارى ممّن كان دخل في الإسلام وتنصّر في ذلك الوقت إلى هذه الغاية، مثل قوم يقال لهم بنو ابلوط، وبنو قيطران وغيرهم مشهورين بحران (1) .
ومن هذا يتبيّن أنّ الزنادقة من الناحية الدينية في نظر المأمون والمؤلّفين المسلمين هم غير المجوس.
ماذا يبقى لدينا بعد إسقاط المجوسية، غير المانوية والمزدكية من أديان الفرس القدماء؟
وبين هذين الاثنين فإنّ المانوية (المنانية) هي الأشهر والأكثر اتباعاً، والأحرى أن ينصرف الذهن إليها وإلى معتنقيها عند الحديث عن الزندقة.
فقد كان المأمون إذا أراد أن يمتحن الزنادقة يظهر صورة ماني لهم ويأمرهم أن يتفلوا عليها، ويتبرؤوا فمَن فعل منهم ذلك نجا ومَن رفض قُتل.
إذن كانت الزندقة هي المانوية أو المانوية والمزدكية. والزنادقة هم أتباع ماني ومزدك، على افتراض صحّة التهمة.
فكيف اتسع اللفظ هذه السعة، حتى أنّك لا تستطيع أن تظفر له بحد أو تعريف، وحتى تحوّل إلى شبح مخيف وإرهاب لا يكتفي برؤوس القائلين بالاثنين. وإنّما يجمع إليهم المسلم الموحّد والملحد الذي ينكر الواحد والاثنين، والشاك الحائر بينهما، والسياسي والثائر واللواط وصاحب الخمرة … ومَن يكره المانوية والمزدكية ويتعصّب ضدّهما ويحاربهما.
كيف تعرّض كل هؤلاء للاتهام بنفس التهمة: الزندقة. فنجا مَن احتال لنفسه ووجد سبيل النجاة، وقُتل مَن عُدم الحيلة لتجنّب القتل؟
____________________
(1) الفهرست لابن النديم، نشر دار المعرفة - بيروت ص445.
أي إرهاب هذا الذي يفقد معه الناس حياتهم على الظن والتهمة، كما كان يفعل المهدي باتفاق المؤرّخين باسم الدين ومعاونة (حراسه) في تهمة لا أحد يعرفها لكي يتجنّبها؟!
يبدو لي أنّ السياسة - كما هي في كثير من الحالات المشابهة الأُخرى - كانت وراء هذا التمييع لمفهوم الزندقة. لا لأنّ هذا المفهوم غير قابل بطبيعته للتحديد، بل لأنّها لا تريد تحديده، وتحرص على إبقائه واسعاً مبهما تستطيع أن تلجأ إليه وتستخدمه كلما أرادت التخلص من خصومها بتهمة ما أسهلها وأسهل اللجوء إليها: تعرض الدين للخطر. ولو كان الدين فعلاً هو المقصود أو لو كان القول بالاثنين فعلاً هو السبب. فلم اقتصر القتل على عدد من الناس مع أنّ القائلين بالاثنين وبأكثر من اثنين من عبدة أوثان ومشركين كانوا يملأون الأرض الإسلامية بكل أقطارها، لا العراق وبغداد وحدهما.
ومع السلطة كان النزاع بين المذاهب الإسلامية المختلفة يلعب في نفس الاتجاه دوراً أقل ما يوصف به أنّه دور المبرّر والمؤيّد للسلطة في القتل وسفك دماء (الزنادقة) تقرّباً إلى الله.
هذا أبو يوسف القاضي، يسأل عن المعتزلة فيجيب بأنّهم الزنادقة (1) وما أظن أبا يوسف وأصحابه حاربوا الزنادقة كما حاربهم المعتزلة. لكنّ أبا يوسف كان جزءاً من السلطة التي لم تكن تقتصد في البطش بخصومها وسفك دمائهم بحجّة الزندقة، وتحت ستار الدين الذي لم يسخر منه أحد كما سخرت السلطة، ولم يتجاوزه ويبتذله أحد كما تجاوزته وابتذلته السلطة. حتى لقد كانت هذه السلطة نفسها بما ارتكبت من أفعال مخالفة للدين، من بين أهم الأسباب التي شجّعت على الزندقة وساعدت على انتشارها وسهّلت الطريق أمام دعاتها.
ولم يكن هم حرّاس الدين وشغلهم إلاّ تبرير ما تفعله السلطة، والدفاع عنه، والتحريض عليه في كثير من الأحيان، عداءً وكرهاً لهذا المذهب أو ذاك من المذاهب الإسلامية المخالفة.
____________________
(1) الفرق بين الفرق ص103.
ولكي تعرف أكثر، الدوافع السياسية لما تعرّض له مَن يسمّون زنادقة، وأنّ هذه الدوافع لا صلة لها بالدين ولا بخطر يتعرض له أو يوشك أن يتعرض له، فسأستعرض الذين قُتلوا وأرى معك هل كان قتلهم لقولهم بالاثنين - على افتراض صحّته - أو اللواط أو الزنا، أو لمجاهرتهم بما يخالف تعاليم وأحكام الإسلام، أم أنّ ذلك قد تمّ لأسباب أخرى غير ما ذكرنا.
وسأبدأ بالبرامكة: أكبر وأخطر مركز من مراكز الزندقة بكل وجوهها في رأي كثير من المؤلّفين.
الفصـل السـا بع:
البـرامكـة
والحديث عن البرامكة كأُسرة كانت في فترةٍ ما ذات سلطان ونفوذ، لا ينازعهما ولا يعلو عليهما إلاّ سلطان الخليفة , أمر معروف لا أراني بحاجة إلى ترداده هنا.
ولذا فسأقتصر في الحديث عنهم على ما يتعلّق بالأسباب التي كانت وراء نكبتهم، وهي الزندقة موضوع بحثنا. فهل كانوا زنادقة حقّاً؟ وهل كان قتلهم وسجنهم بسبب الزندقة وعلى الزندقة؟
ولا أكتمك أيّها القارئ أنّني تردّدت، بل تحرّجت، بل خفت وأنا أهم بالكتابة فيه. ذلك أنك تستطيع ودون أي تردد أو حرج أو خوف، أن تتهم البرامكة وترميهم بكل ما شئت من تهم دون أن تتعرّض لشيء ممّا يسوء، بل ربّما ستكون به العربي المسلم المدافع عن العروبة والإسلام.
أمّا أن تحاول تبرئة قوم من غير العرب، ومتهمين بالزندقة ولا يتحدث عنهم المؤرّخون منذ أكثر من اثني عشر قرناً إلاّ كذلك، فهذا ما عليك أن تحسب له ألف حساب، وتضع أمامك نتائج تراها ونتائج لا تراها، قد يكون من بينها التهم التي لحقت بهم، ولا أريد أن أبعد، فأقول المصير الذي لحقهم.
لكن لمن سنترك كتابة التأريخ إذن؟ إذا كان الكاتب يخاف أن يكتب، والناشر يخاف أن ينشر، والقارئ يخاف أن يقرأ أو لا يقرأ إلاّ ما يسمح له بقراءته.
أيّ تأريخ هذا الذي يكتبه الخائفون وينشره الخائفون ويقرأه الخائفون؟!
إنّ التأريخ هو أمانة النفوس الحرّة والعقول المفتوحة والضمائر التي تسبق القلم وترده كلما أراد أن يحيد عن الحق أو يداهن في الحق، بـ (لا) قوية، هي التعبير عن الاحترام للحقيقة وكاتبها وناشرها وقارئها. لا مجموعة الأكاذيب التي تُقدّم على أنّها تأريخ، صنعه تعصّب وحمق وغباء، وفرضه أصحاب السلطة ورجالها ومتعهّدوها.
وهل يخيف السلطة شيء أكثر من هذا الفكر الحر، وهل يرهبها شيء أكثر من هذا الضمير الحر الذي لا يباع ولا يشترى، وهذا القلم الحر الذي يفضّل صاحبه أن يكسره بيده على أن يجعل منه أداة بيد الحاكمين، أو سلعة يمتلكها مَن يملك ومَن يدفع.
وأعود الآن إلى التأريخ وإلى موضوع البرامكة منه.
فهل كان البرامكة زنادقة؟ وهل كانت الزندقة سبب نكبتهم؟
يقول الجهشياري في الوزراء والكتاب: (ويحيى بن خالد - ابن برمك - وهو أوّل مَن زاد في الكتب (وأسأله أن نصلّي على محمد عبده ورسوله). (وأمر بإجراء القمح على أهل الحرمين وتقدّم بحمله من مصر إليهم، وأجرى على المهاجرين والأنصار وعلى وجوه أهل الأمصار وعلى أهل الدين والآداب والمروءات) (1) .
ويقول (حج يحيى وسأل الرشيد الأذن في المقام بمكّة فأذن له فانصرف إلى مكّة سنة 181) (2) .
وفي عام 185 استأذن يحيى الرشيد في العمرة والجوار فأذن له فخرج في شعبان واعتمر عمرة شهر رمضان، ثم رابط بجدة إلى وقت الحج ثم حج (3) هذا عن يحيى، أمّا عن ابنه الفضل فيقول الجهشياري: (وقلد - يعني الرشيد - الفضل المغرب كله … ولمّا صار الفضل إلى خراسان أزال سيرة الجور وبني الحياض والمساجد والرباطات … وأمر بهدم البيت المعروف بالنوبهار - وهو بيت للبرامكة في بلخ كانوا يضاهون به بيت الله - فلم يقدر على هدمه لوثاقته وعظم المؤونة عليه فهدم منه قطعة وبنى فيها مسجداً …) (4) .
وكان الفضل لا يشرب النبيذ ويقول: (لو علمت أنّ الماء ينقص مروءتي ما شربته أبداً) (5).
فهل رأيت فيما فعله يحيى أو ابنه الفضل شيئاً ممّا يفعله الزنادقة أو شبيهاً به أو قريباً منه، على أي وجه أخذت الزندقة وبأي وجه فهمها المؤرّخون وأصحاب المقالات؟!
هل رأيت فيه إلاّ ما يفعله المسلم الملتزم البعيد عن الزندقة والزنادقة؟! وفيما دون ما عمله يحيى والفضل ما يبعد عنهما الزندقة والاتهام بها.
أمّا جعفر فاسمع قول الجهشياري فيه (وغلب جعفر على الرشيد غلبة شديدة حتى صار لا يقدّم عليه أحداً، وأنس به كل الأُنس، وأنزله بالخلد بالقرب من قصره) (6) .
فهل يمكن أن يكون جعفر زنديقاً، وهو يلازم الرشيد منذ كان طفلاً حتى صار أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، فلا يكتشفه ولا تكتشفه عيون المهدي أبيه الذي تجرّد لملاحقة الزنادقة. ولا يزداد من الرشيد مع الأيام إلاّ قرباً ولا علاقته به إلاّ وثوقاً؟!
____________________
(1) الوزراء والكتّاب ص177.
(2) تأريخ الطبري ج8 أحداث سنة 181 ص268.
(3) تأريخ الطبري ج8 أحداث سنة 185 ص273.
(4) الوزراء والكتّاب ص191.
(5) الوزراء والكتّاب ص194 والطبري ج8 ص299.
(6) الوزراء والكتّاب للجهشياري ص189.
أكان الرشيد صديقاً للزنادقة ولا أقول زنديقاً، أم كان جعفر بريئاً من الزندقة التي يعالجها المؤرّخون وكأنّها السبب في نكبة البرامكة؟!
ولكي لا أبدأ تأريخ البرامكة من حيث انتهى، فسأعود قليلاً إلى الوراء حيث بداية هذا التأريخ، لتكون نهايته واضحة في دوافعها وأسبابها، بعيدة عن نوازع الحقد والاتهام المعتادين.
أبدأ إذن بأول مَن عُرف من رجالهم، وهو خالد بن برمك والد يحيى وجد الفضل وجعفر. والذي كان من النابهين في الدعوة العباسية قبل أن تصبح دولة، وكان من النابهين فيها بعد أن أصبحت دولة، حتى تولّى ديوان الخراج لأبي العباس السفاح أوّل خليفة عباسي، ثم تولّى الري وطبرستان وديناوند للمنصور وأقام فيها سبع سنين.
وبعد السفاح والمنصور، أنفذ المهدي خالداً إلى فارس عاملاً عليها، وكانت وفاته عام 163 في زمن المهدي.
وما أظن خالداً، حين انضمّ إلى الدعوة العباسية وحارب في صفوفها وحاز ثقة قادتها، كان زنديقاً.
وما أظن قادة الدعوة، وقد رفعوا مكانه وأعلوا منزلته، وهم يعلمون أنّه زنديق.
ولأفترض أنّهم فعلوا ذلك لحاجتهم إليه خلال فترة الدعوة، وبعد الدعوة وقيام الدولة العباسية؟ فهل كانت هذه الدولة تحتاج زنديقاً أو تقرّب زنديقاً؟ وهي التي ما قامت إلاّ باسم أهل بيت النبوّة، لإعادة مجد الإسلام الذي عبث به الأمويون، وعطّلوا أحكامه وقرّبوا مَن هو متّهم في دينه، بل كان بين خلفائهم مَن اتهم هو بالزندقة كالوليد بن يزيد، وما كانت الدعوة لتنجح، وما كانت الدولة لتقوم لولا ما أُحيطت به من هالة دينية قوية.
هل كان السفّاح وبعده المنصور وبعدهما المهدي، الذي جرّد السيف في الزنادقة، وكان يقتل على التهمة والظنة فيها، سيبقي على زنديق معروف، ثم لا يكتفي بذاك حتى يولّيه فارس عاملاً عليها؟!
هذا من حيث العقيدة والعمل وما يتصل بهما. أمّا من حيث الأخلاق فيقول عنه الجاحظ (وحدثني تمامة - ابن أشرس كما أرى - قال: كان أصحابنا يقولون لم يكن يرى لجليس خالد دار إلاّ وخالد بناها له، ولا ضيعة إلاّ وخالد ابتاعها له …) (1) .
(وكان خالد أوّل مَن سمّى المستميحين ومن يقصد العمال لطلب البر الزوار وكانوا يسمون قبل ذلك السؤال فقال خالد أنا استقبح لهم هذا الاسم وفيهم الأحرار والأشراف …) (2) .
وكان سخيّاً جليلاً ثريّاً نبيلاً كثير الإحسان كما يصفه الجهشياري (3) .
وبعد خالد يأتي ابنه يحيى الذي كان الرشيد يخاطبه بالأُبّوة، والذي قلّده أمر الرعية حين ولي الخلافة عام 170 قائلاً: (وقد قلّدتك أمر الرعية وأخرجته من عنقي إليك …) (4) .
ثم يجدد ذلك بعد ثمان سنوات من خلافته فيفوّض أُموره كلها إلى يحيى بن خالد.
وكان يحيى مختصاً بالرشيد منذ حياة أبيه، وهو الذي مهّد له أمر الخلافة وتحمّل في سبيل ذلك الكثير من العناء، حتى عرّض حياته للخطر حين عزم الهادي على عزل الرشيد من ولاية العهد وجعلها في ابنه. فلم يترك يحيى وسيلة يصرف بها الهادي عمّا عزم عليه، ويقنع بها الرشيد بألاّ يتنازل عن حقّه في الخلافة إلاّ توسّل بها. وقد نجح في مسعاه فعدل الهادي عن عزمه وأعاد للرشيد حقّه في الخلافة بعده (5) .
وحين تولّى الرشيد الخلافة بعد وفاة الهادي. كان طبيعياً أن يتقلّد يحيى ما قلّده الرشيد من أُمورها. وبقي يحيى حتى حصول النكبة مناصحاً للرشيد قائماً بما أوكل إليه خير قيام، لم تعرف عنه خيانة أو غدر.
____________________
(1) الوزراء والكتّاب ص150.
(2) نفس المصدر والصفحة، والأغاني ط دار الكتب ج3 ص173.
(3) نفس المصدر والصفحة، وفي تأريخ بغداد للخطيب البغدادي ج12 ص336 ترجمة الفضل بن يحيى أنّ الذي سمّاهم كذلك هو الفضل لا جدّه خالد.
(4) الوزراء والكتّاب ص177، ومروج الذهب ج3 ص337، والطبري ج8 أحداث سنة 170 ص233.
(5) تاريخ الطبري ج8 أحداث سنة 170 ص230، ومروج الذهب ج3 ص333، والوزراء والكتّاب ص170.
ولقد كان يحيى حليماً جواداً عاقلاً وفيّاً، ما شئت من صفات النبل إلاّ وجدتها فيه.
يقول عنه الجهشياري: (وكان يحيى يهضم نفسه إذا استكثر شيء يكون منه من الجود) (1) .
ويقول عنه عبد الصمد بن علي (2) (ما رأيت أكرم من يحيى نفساً، ولا أحلم منه، جعل على نفسه ألاّ يكافئ أحداً بسوءٍ فوفّى) (3) .
ومع يحيى وإلى جانبه كان ابناه الفضل وجعفر يتوليان أعلى المناصب ويتمتعان بما لم يعرف لغيرهما من النفوذ والسلطة. تولّى الفضل المشرق كله من النهروان إلى أقصى بلاد الترك، وجعفر المغرب كله من الأنبار إلى أفريقيا.
وبقي يحيى وأبناؤه يتقلّدون أعلى الوظائف حتى جاءت نكبة عام 187.
سبعة عشر عاماً والبرامكة يحكمون. وأربعون عاما قبلها وهم يعملون مع العباسيين، فلم يعرفوا عنهم زندقة ولم يعرفها عنهم الناس - والحاسدون لهم كثير - ولم يتهموهم بها.
بل إنّ الرشيد نفسه الذي نكبهم وقتل جعفر بن يحيى لم يتهمهم، ولم يتهم مَن قتل منهم بالزندقة.
كيف استطاع البرامكة أن يكتموا أنفسهم وعقيدتهم طول تلك المدّة، فلم يكتشفها المعاصرون لهم، مع علوّ مقامهم وكثرة أعدائهم والحاسدين والطامعين في إزاحتهم والحلول محلّهم.
____________________
(1) الوزراء والكتّاب ص164.
(2) ابن عبد الله بن عباس عم السفّاح والمنصور وأحد كبار العباسيين وممّن صحب السفّاح في رحلته من الحميمة إلى الكوفة بعد مقتل إبراهيم الإمام.
(3) الوزراء والكتّاب ص203.
هل قفز البرامكة عبر الزمان فظهروا فجأة في تاريخ العباسيين؟ أم أنّ علاقتهم بهم امتدت عقوداً من السنين من خليفة إلى خليفة، وكلهم متشدّد في أمر الدين يدعم به أركان حكمه. وكانت الزندقة هي أشدّ التهم وأخطرها في ذلك العهد، حتى كان المهدي يقتل فيها على الظنة والتهمة كما ذكرنا، وحتى عيّن شخصاً عهد إليه بملاحقة المتهمين بالزندقة سمي (صاحب الزنادقة).
فكيف أفلت البرامكة من كل هؤلاء فلم يرمهم واحد بالزندقة، ولم يقل عنهم واحد بأنّهم زنادقة، وقد أتهم مَن لا يقاس بهم ومَن لم يكن له من الأعداء والحاسدين ما كان لهم.
ثم يأتي بعد ذلك من (يزندقهم) تبريراً لما جرى عليهم واعتذاراً عمّا فعلته السلطة معهم. ويطلب منك أن تقتنع بما يقول!
أمّا أنا فلا أريد أن أخسر عقلي، فأقبل ما يقال عن زندقة البرامكة وأنّها كانت وراء نكبتهم والسبب فيها.
وإذا كنت أرفض الزندقة كتهمة جرت على البرامكة ما نزل بهم، فإنّ هذا لا يعني مطلقاً عدم وجود أسباب أُخرى لنكبتهم. منها ما اتصل بالبرامكة أنفسهم، ومنها ما اتصل بالرشيد، ومنها ما اتصل بهؤلاء الكثر من الحاسدين والمتربّصين والساعين لإزالة ما كان البرامكة ينعمون به من مجد وسلطان، ومحاولة الحلول محلّهم.
لقد كان البرامكة ناساً من الناس. ليسو ملائكة ولم يكن من بين أسلافهم أبو ذر أو عمار، فتحت لهم الدنيا أبوابها كما لم تفتحها لأحد، ووجدوا بين أيديهم المال والجاه والسلطان.
وكانوا قوماً ذوي فضل ونبل وسخاء، فلم يبخلوا بمالهم أو جاههم أو سلطانهم.
وكان الشعراء، وهم الراكضون في ذلك العصر وراء المال والجوائز، يتزاحمون على أبوابهم أكثر ممّا يتزاحمون على باب الخليفة. ينظمون فيهم أروع ما يستطيع الشعراء أن يأتوا به من عالي الشعر ورفيعه، حتى أضطر البرامكة إلى تخصيص واحد يرفع إليه الشعراء قصائدهم فيهم، لتكون الجوائز حسب ما يرى من جودة الشعر.
وإلى جانب الشعراء كان ذوو الحاجات من الناس، ومن العاملين في وظائف الدولة، يتزاحمون هم أيضاً على أبوابهم لقضاء حوائجهم.
ولم يكن البرامكة يردون من يمكنهم إجابة طلبه ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً.
ومع الأيام كان نفوذ البرامكة يقوى ويتّسع حتى لكأنّ الدولة هي دولة البرامكة، يساعدهم على ذاك وفرة المال في أيديهم وسخاؤهم به وبذلهم له.
وكان هذا وحده كان كافياً لأن يثير حفيظة الكثيرين وحسد الكثيرين، وسعيهم للإطاحة بهم كما هي الحال في كل زمان.
وبين هؤلاء من لم يكن يرى نفسه دونهم كالفضل بن الربيع الذي حجب أبوه لأوائل الخلفاء العباسيين، والذي لم يحسن البرامكة التعامل معه ولم يقدروه قدره.
ولهذا كان الفضل، بالأضافة إلى الآخرين ممن يكره البرامكة ويحقد عليهم، يسعى بهم وينال منهم ويكشف أسرارهم وأخبارهم إلى الرشيد أو من يوصلها إليه.
ولم يكن الرشيد مغمض العينين عمّا يجري. كان يرى اتساع نفوذ البرامكة وغلبتهم على الناس.
وما أظنّه إلاّ قد فكّر فيما يمكن أن ينتهي إليه وضع كهذا، وأمامه مثال أبي مسلم وجدّه المنصور وهو غير بعيد.
وما أظنه إلا كان يعد ويهيّئ للتخلّص ممّن شركوه في سلطته وربّما تجاوزوها أحيانا فقطعوا بالأُمور دون الرجوع إليه وأخذ رأيه.
ويبدو أنّ البرامكة، خصوصاً جعفر، قد تعاملوا مع الرشيد مطمئنين معتمدين على سابق دالتهم عليه، وماضيهم في خدمته ومكانهم منه، فأمنوا وأساؤوا تقدير الظروف المحيطة بهم والدسائس التي تحاك ضدهم. ولم يفكروا في بطش السلطان الذي لا يوقفه سابق خدمة، ولا قديم ود، ولا يتسامح في ركوب أي أمر إذا رأى فيه ما يهدّد عرشه أو يعرّضه لخطر التهديد يوماً ما.
وكان على البرامكة أن يعرفوا ذلك فيكونوا أكثر حذراً، وأشد احتراساً ولا يقعوا فيما وقعوا فيه، مع تحذير يحيى الأب المجرب العاقل، ومع ما كان يبدو في سلوك الرشيد إزاءهم خلال الفترة التي سبقت نكبتهم، ممّا يثير الريبة ويدفع إلى الحذر والاحتراس.
وهكذا جاء اليوم الذي كان لا بد أن يجئ. وأخذ البرامكة فيه بداية عام 187 بتدبير حازم على غفلة منهم، وعلم أو ما يشبه العلم ممّن كان يرقب الأحداث ويحسب نتائجها.
تلك هي أسباب نكبة البرامكة، سياسية تتصل بالحكم والحاكمين ولصراع السياسي بين أطراف، يغلب فيه اليوم طرف وغداً آخر، في دولة الفرد التي يكاد تأريخنا لا يعرف غيرها من أشكال الحكم.
إنّها سياسية بعيدة عن الزندقة وما يتصل بها، بعيدة عن الدين وما يتصل به، وإلاّ فكيف أُفسّر سكوت الرشيد سبع عشر سنة وسكوت مَن قبله عنهم كما ذكرت؟!
أكان الرشيد قد عرف زندقة البرامكة طول تلك المدة وسكت، فلم يعرض لهم ولم يمسّهم بسوء؟ أم لم يكتشفها ويكتشفهم إلاّ في اليوم الذي جرت نكبتهم فيه.
وكيف أُفسّر حج بيت الله وبناء الرباطات والمساجد وهدم النوبهار؟ أكان ذلك رياء ونفاقاً؟ لكن هذا الجواب الميسور لمَن أراده، سيصدق على كل الحالات المشابهة الأُخرى، ولن يقتصر على البرامكة وحدهم، وهم لم يكونوا مجبرين ولا مكرهين على ما فعلوا، ولم ينجهم بعد ما فعلوه من تهمة الزندقة.
ثم أي مقياس سنتخذ في الحكم على الناس، إذا نحن تركنا ظواهرهم وأعمالهم وما يدل على صدق نواياهم؟!
وكيف أُفسّر إسراع الرشيد إلى قبض ضياعهم وأموالهم في نفس اليوم الذي تمّ فيه القبض عليهم. ذلك أن أموال البرامكة كانت ولا شك من بين أهم أسباب قوّتهم. والقضاء عليهم لا بد أن يرافقه القضاء على أسباب تلك القوّة: المال.
يؤكّد ذلك الحوار الذي جرى عقب سجنهم بين الرشيد وبين يحيى والذي ينقله لنا الجهشياري في الوزراء والكتاب (1) فهذا الحوار ينصب كله على المال وطرق إنفاقه. لم يشر فيه الرشيد إلى شيء من عقيدة البرامكة ولم يذكرها ولم يلمح لها. وكان حرياً بالرشيد أن يذكرها ويتخذ منها ذريعة لتبرير ما أوقعه بهم في حواره ذاك.
وكيف أُفسّر اختلاف الحكم فيهم وهم أهل بيت واحد: أب وأبناؤه، فيتناول القتل بعضهم دون بعض. يتناول أقربهم للرشيد وأحبّهم إليه وأمكنهم منزلة في قلبه، ومَن لم يكن يصبر على فراقه ساعة من ليل أو نهار.
____________________
(1) الوزراء والكتّاب ص243.
ثم لماذا لم يعلن الرشيد اتهام البرامكة بالزندقة على المسلمين، ولم تجر مناظرتهم عليها في مجلس يحضره العلماء ورجال الدين، كما جرت العادة قبله وبعده، حيث كان المتّهم بالزندقة يحضر وتتم مناظرته ويستتاب فينجو مَن تثبت براءته أو توبته. ولا يقتل مَن يقتل إلاّ بعد بيّنة وإصرار ورفض التوبة عنها، ما لم يكن الاتهام بالزندقة ستاراً لدوافع سياسية لا يراد الكشف عنها.
ما الذي منع الرشيد من مواجهة جعفر ومساواته بالآخرين ممّن اتهموا بالزندقة حين يطلبون مواجهة الخليفة لإثبات أو إعلان البراءة ممّا اتهموا به؟! وكان جعفر قد سأل مَن جاء لأخذ رأسه وألحّ في السؤال، أن يواجه الرشيد ويراه أو يراجعه في أمره.
أكان الرشيد خائفاً من مواجهة متهم بالزندقة يريد أن يثبت براءته منها أمامه؟ وماذا في ذلك من ضرر لو أثبت أنّه غير زنديق؟ بل في ذلك كسب للدين وصيانة لدم مسلم لم يرتكب جرماً، أو تاب عن جرمٍ ارتكبه.
لقد أرسل الرشيد مَن يأتي برأس جعفر لا مَن يأتي بجعفر. ولم يكن جعفر محارباً ولم يُؤسر في ساحة حرب، ولم يتهم في شأن من شؤونها فتقتضي ضرورات الأمن سرعة قتله والتخلّص منه.
ولم يكن هناك هياج أو فتنة فيخاف منه أو من الانتظار به حتى اليوم التالي.
ثم كيف أفسّر أخيراً هذه القسوة أو هذا التمثيل الذي أعقب مقتل جعفر، إذ ينقل المؤرّخون أنّ الرشيد أمر بقطع جثّته ونصب كل قطعة على أحد جسري بغداد، ونصب رأسه على الجسر الثالث فيها (1) . وأنّ جثته بقيت معلّقة من بداية صفر حتى نهاية ذي الحجّة حيث أمر الرشيد بإحراقها (2) .
وهذا ما لم يرو ولم ينقل عن كل الذين اتهموا بالزندقة وقتلوا فيها. وهو يعكس حقدا شخصيا عميقا تملك الرشيد فتصور أن ذلك مما يشفي غيظه من جعفر.
وهنا قد يرد إلى ذهني ما يشير إليه بعض المؤرّخين من زواج جعفر بالعباسة أخت الرشيد، وشرط الرشيد ألاّ يدنو منها جعفر ولا يخلو بها. وأنّ هذا الشرط لم يتحقق بفعل جعفر أو العباسة أو كليهما، فحملت العباسة سرّاً من جعفر ووضعت غلاماً بعثت به إلى مكّة مع مَن يخدمه ويرعاه هناك، وأنّ الرشيد قد علم بالأمر من بعض الجواري، وهو ما أحنقه على جعفر خصوصاً.
____________________
(1) تاريخ الطبري ج8 أحداث سنة 187 ص 296 والوزراء والكتاب ص234.
(2) الطبري ج8 أحداث سنة 187 ص317.
وهذه القضية - وأنا لا أريد أن أناقش صحّتها الآن - وإن كانت قضية شخصية وتبقى شخصية لو تعلّقت بواحد غير الرشيد. لكنّها بالنسبة للرشيد وفي الظروف التي وقعت فيها قد تحولت إلى قضية سياسية جاءت لتضاف إلى العوامل السياسية التي رأيناها والتي ساهمت مجتمعة في نكبة البرامكة.
على أنّي أسأل بشأن هذه القضية عن الملوم فيها؟ أكان الرشيد يريد أن يزوّج أُخته ثم يمنعها أو يمنع زوجها من الاقتراب منها والخلو بها، ومنعهما ممّا لا يكون الزواج زواجاً إلاّ به؟!
أكان زواج جعفر من العباسة زواجاً مع وقف التنفيذ؟! وهو ما لم يعرفه المسلمون من قبل ومن بعد. وفيما هو دون ذلك أتهم مَن أتهم منهم بالبدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهل سيرضون لخليفة المسلمين وأمير المؤمنين أن يكون مأواه النار؟! ولعلّ من المناسب أن أكمل الحديث عن هذه القضية بما يرويه المسعودي، وكيف أنّ العباسة التي كانت تحب جعفراً قد احتالت حتى حملت منه. ثم ينهي كلامه وكأنّه يجعل من قضية الزواج هذه، سبب نكبة البرامكة.
واستغربت مذهب المسعودي هذا، لأسباب منها ما يتعلّق بالعباسة. فالحمل لا بد أن يظهر على المرأة الحامل بعد شهرين أو ثلاثة حتى تضع ما في بطنها. وهذا قد يأخذ من الوقت أشهراً تبلغ أو تتجاوز الستة، كان على العباسة أن تنقطع وتغيب خلالها عن مجلس الرشيد. أفلم يسأل الرشيد عن سر غيابها الطويل هذا، وهو الذي لا يصبر عنها ولا يكتمل سروره إلاّ باجتماع الاثنين هي وجعفر كما يقول المسعودي؟!
ومنها قول المسعودي، بعد سرد حكاية الزواج وقتل جعفر (ثم قال - يعني الرشيد - يا ياسر، وهو الذي تولّى قتل جعفر بأمر الرشيد، ائتني بفلان وفلان فلمّا أتى بهم قال لهم: اضربوا عنق ياسر فإنّي لا أقدر أن أنظر إلى قاتل جعفر).
ورغم أنّ قتل الناس هو أسهل ما يمارسه الخلفاء المسلمون من هواية. لكنّي أرفض رأي المسعودي هنا. فإذا كان حقّاً ما يقول من أنّ الرشيد لا يقدر أن ينظر إلى قاتل جعفر. فلِمَ يطلب بعد ذاك - وقد قتل جعفر الذي لا يستطيع أن ينظر إلى قاتله - أن تقسم جثة جعفر إلى نصفين، يعلق كل نصف على جسر ويعلّق الرأس على جسر ثالث؟
إنّ فعل الرشيد بجعفر، حتى بعد قتله، يؤكّد حقداً قوياً طويلاً لا يتفق مع ما يذكره المسعودي، من قتل ياسر بعد ما جاء برأس جعفر، وكأن الرشيد قد ندم على فعله، أو كأن فعله كان نزوة من نزوات الملوك حين يأتون في ساعة غضب ما يندمون عليه بعد زواله.
وأخيراً فإنّ رواية المسعودي هذه لا تقدّم لنا تفسيراً لما حلّ بالبرامكة - غير جعفر - من سجن وتعذيب ومصادرة أموال، حتى كانت أم جعفر بعد ذاك لا تجد ما تنام عليه، وحتى كادت تموت فرحاً حين أعطاها محمد بن عبد الرحمان الهاشمي خمسمائة درهم.
إلى هنا أنتهي من حديث البرامكة وجعفر ومن حديث نكبتهم وأسبابها، وبعد ما بينها وبين الزندقة.
ومع جعفر، قتل واحد من الذين ترد أسماؤهم بين المتهمين بالزندقة، ذلك هو أنس بن أبي شيخ، كاتب جعفر بن يحيى.
وما دمنا قد عرفنا الأسباب التي كانت وراء اتهام جعفر بالزندقة وقتله، فأظن من السهل بعد ذاك أن نعرف الأسباب التي كانت وراء اتهام وقتل كاتبه أنس، الذي لم يتهم ولم يقتل إلاّ بسبب جعفر واتصاله الوثيق به. وربّما اطلاعه على ما كان بينه وبين الرشيد من أسرار، لم يكن الرشيد يريد أن يعلم أحد بها أو يبقى أحد ممّن يعلم بها.
وهكذا ختمت حياة هذا الرجل بالقتل مع تهمة الزندقة، التي سارع المؤلّفون إلى إلصاقها به، تبرئةً للقاتل واعتذاراً عنه.
الفصل ال ثامن:
آل سهل
وهذه أُسرة أُخرى من الأُسر التي لمعت في فترة من فترات الحكم العباسي هي فترة المأمون.
كان الأب مجوسياً فأسلم ثم أسلم الابنان.
فهم لم يكونوا زنادقة في ماضيهم، ولم يكونوا زنادقة بعد أن تخلّوا عن ماضيهم.
فمن أين أتاهم الاتهام بالزندقة.
وقبل أن نسترسل في الحديث عنهم لا بد أن نعرف أوّلاً: مَن هي هذه الأُسرة التي نريد الحديث عنها.
هم آل سهل بن زاذانفروخ كما يذكر الجهشياري، أو عبد الله السرخسي كما يرد عند ابن خلكان في ترجمة الحسن بن سهل أو عبد الله وحده، كما في تأريخ بغداد للخطيب البغدادي.
وكانت بدايتهم مع البرامكة، الذين قدّموهم وأوصلوهم إلى الرشيد والمأمون، في قصة يرويها صاحب الوزراء والكتّاب.
ثم نبه الفضل والحسن ابنا سهل وعلا شأنهما، حتى إذا كانت الفتنة بين الأمين والمأمون بسبب عزل المأمون من ولاية العهد، كما هو معروف، والحروب التي دارت بين الطرفين، كان الفضل بن سهل الذي لُقّب بذي الرياستين: السيف والقلم، وأخوه الحسن، من أكبر أعوان المأمون وأشدّهم بلاء في تثبيت أمره، وأبعدهم أثراً في الانتصار الذي انتهى بإعلان المأمون خليفة بعد مقتل الأمين.
ولم ينس المأمون للفضل مواقفه فقد فوّض إليه الأُمور كلها يقضي فيها برأيه.
ثم زاد على ذلك بأن كتب كتاباً على نفسه جاء فيه (.. وقد جعلت لك بعد ذلك مرتبة من يقول في كل شيء فيسمع منه، ولا تتقدمك مرتبة أحد …)
وكان الفضل كما يقول عنه الجهشياري (سخيّاً سرياً نبيل النفس كثير الأفضال، يذهب مذاهب البرامكة في ذلك). (قد حرم النبيذ وحظر شربه وأمر بعقوبة شاربه).
ويقول عنه الخطيب: إنّه كان: (أكرم الناس عهداً وأحسنهم وفاء ووداً، وأجزلهم عطاء وبذلاً، وأبلغهم لساناً وأكتبهم يداً).
وكل هذا أثار حسد الآخرين وحفيظتهم وسعيهم للإيقاع بالفضل. ولقد ساعد الفضل على نفسه بمواقفه من بعض كبار القادة وأصحاب النفوذ، ومَن لا يرى له من دور يفوق دوره في نصرة المأمون وتثبيت حكمه. ومن بين هؤلاء: طاهر بن الحسين، وعبد الله بن مالك الخزاعي، وهرثمة بن أعين الذي قتل بعد سجنه بأيام وقيل إنّه مات فيه.
وكان بنو هاشم من جانبهم قد غاظهم غلبة الفضل على المأمون واستبداده بالأُمور دونه ودونهم.
وكانت القضية الأهم التي أُثيرت فأثارت مخاوفهم وقلقهم، والمأمون ما يزال بعد في مرو، هي قضية ولاية العهد التي عقدها المأمون للرضا علي بن موسى بن جعفر هناك. وهي تعني إخراج الخلافة من آل العباس ونقلها إلى آل علي.
ولم يكن العباسيون طبعاً ومعهم أنصارهم الذين قاتلوا معهم، وكان من بين ضحاياهم عدد من آل علي، مستعدين لأن يتنازلوا عن الخلافة إلى غيرهم حتى لو قبل الخليفة وتنازل عن حقّه فيها. فبادروا إلى مبايعة إبراهيم بن المهدي عم المأمون، واجتمعوا عليه ودارت معارك طويلة بين إبراهيم وبين الحسن بن سهل والي العراق من قِبل المأمون.
ولم يكن الفضل بعيداً عن الاتهام بتدبير أمر البيعة، وهو ما زاد من كره العباسيين وحقدهم عليه.
وبالإضافة إلى ما سبق وربّما الأهم ممّا سبق، هو ما اكتشفه المأمون من أنّ الفضل كان يكتم عليه الكثير من الأُمور ولا يطلعه إلاّ على ما يريد أن يطلعه عليه. من ذلك مثلاً ما كان يجري في بغداد من تنصيب خليفة ونشوب حرب واضطراب أمن. وهو ما لم يعلمه المأمون على حقيقته إلاّ فيما بعد وعن غير طريق الفضل.
وكان لا بد لذلك أن يترك أثره في نفس المأمون، الذي لم يعد يجد في الفضل إلاّ عنصر ضعف في موقفه، من آل بيته العباسيين ومن عدد من قادة جيشه وأعوانه.
وقد اضطرّ المأمون بعد الأنباء الخطيرة التي بلغته عن الوضع في العراق، واضطراب الأمر فيه، أن يترك مرو عائداً إلى بغداد. وفي سرخس في طريق العودة اغتيل الفضل بن سهل. اغتاله أربعة وهو في الحمام في دار المأمون كما يقول المسعودي (1) وكانوا من حشم المأمون كما يقول الطبري (2) .
وحين واجههم المأمون اتهموه بأنّه هو الذي أمرهم بقتله، كما في الطبري وابن الأثير (3) ، فأمر بهم المأمون فضُربت رقابهم.
وهكذا تتكرّر قصة البرامكة بعد خمسة عشر عاماً فقط: سورة السلطان واتساع النفوذ، وكثرة الحاسدين والطامعين والساعين، ثم الخليفة الذي قد يغفر أي شيء، ويتسامح في أي شيء إلاّ مشاركته في ملكه أو إضعافه أو تهديده.
وإذا كان هناك من فرق بين القصّتين فهو أنّ المأمون أراد التخلّص من الفضل، مع بقائه في الظاهر بعيداً عن قتله، بريئاً من تبعته غير راضٍ ولا مشارك ولا عالم به.
وليس كثيراً أن يقتل أربعة من هؤلاء الذين لا يستطيعون إلاّ تنفيذ ما يؤمرون به، وليسوا من أصحاب الجاه ولا من ذوي العصبيات، وهم شهادة البراءة للمأمون.
وذلك خلافاً للبرامكة والرشيد، إذ كان الآمر بالقتل والحبس هو الخليفة نفسه معلناً ذاك مظهراً له سعيداً به.
بقي ما يقوله المسعودي في بداية حديثه عن المأمون، من أنّ قتل الفضل كان بسبب جارية أراد المأمون شراءها فضايقه الفضل عليها.
وما أظن المسعودي مع علمه وفضله ممّن يجوز عليه ذلك، وهو لا يجوز على مَن هو دونه. فلو كان للفضل ألف جارية وأرادهن المأمون أو بدا منه ما يشير إلى أنّه أرادهن لجهزهن وحملهن كلهن إليه. فليس الفضل من الغباء بحيث يخاطر بكل ما وصل إليه وبلغه، وربّما بحياته، لحساب جارية في عصر لا بضاعة فيه أروج وأكثر شيوعاً وانتشاراً من الجواري وأسهل امتلاكاً لها.
وبعد فأين هي الزندقة في كل ما مرّ بنا؟ وفي أي وجه من وجوهها على - كثرتها - يبدو لنا الفضل زنديقاً أو قريباً من الزنادقة أو صاحباً أو جليساً أو مقرّباً إليهم، وقد حرم على نفسه حتى الشرب وعاقب عليه. هل هناك غير السياسة والصراع السياسي ومَن يحسن ومَن لا يحسن الخوض فيه.
وأقل من الفضل وأهون شأناً وأبعد عن الاتهام بالزندقة أخوه الحسن، الذي يكفي في نفيها عنه أن يكون المأمون نفسه قد تزوّج ابنته بوران، في حفلة تشبه الأسطورة أو تتجاوزها على أنّ الحديث عن الحسن هنا لا محلّ له، وهو لم يقتل ولم يسجن ولم يعذب، وقد خصصت حديثي كما قلت منذ البداية للذين قتلوا وسجنوا، أو عُذّبوا بتهمة الزندقة.
____________________
(1) مروج الذهب طبعة دار الأندلس - بيروت 1981 ج3 ص441
(2) تأريخ الطبري ج8 أحداث سنة 202 ص565.
(3) تأريخ الطبري ج8 أحداث سنة 202 ص565 وابن الأثير ج5 أحداث سنة 202 ص445.
الفصل ال تاسـع:
عبد الله بن أبي عبيد الله
وهذا شخص قتلته السياسة ولم تقتله الزندقة، حتى لو صحّ ما اتهمه بعض المؤرّخين أنّه كان زنديقاً.
قتلته السياسة ولم يكن هو سياسياً ولا طرفاً في الصراع السياسي، الذي كان دائراً آنذاك في عاصمة الخلافة، وفي كل صقع من أصقاعها.
ولكن لسوء حظّه أنّه كان ابن واحد من أطراف ذلك الصراع.
هو عبد الله بن أبي عبيد الله الأشعري بالولاء، وزير المهدي وصاحب أمره والمقدّم عنده.
اختلف أبو عبيد الله هذا مع طرف قوي آخر هو الربيع بن يونس والد الفضل بن الربيع في قصة يرويها المؤرّخون.
وبلغ من حقد الربيع على أبي عبيد الله أنّ الربيع أقسم بـ (الله الذي لا إله إلاّ هو لأخلقن جاهي، ولأنفقن مالي حتى أبلغ مكروه أبي عبيد الله، ثمّ جعل يضرب ظهراً لبطن ويضطرب يميناً وشمالاً فلا يجد مساغاً، ثم ذكر القشيري وكان أبو عبيد الله أساء به وحجبه فاستحضره وقال قد علمت ما ركبك به أبو عبيد الله فهل عندك في أمره حيلة؟ قال له: ليس بجاهل في صناعته وأنّه لأحذق الناس، وما هو بظنين فيما يتقلده؛ لأنّه أعف الناس حتى لو كان بنات المهدي في حجره لكان لهنّ موضعاً، وليس بمتهم بانحراف عن هذه الدولة، لأنّه ليس يؤتى من ذلك، وليس يتهم في دينه؛ لأنّ عقده وثيق، ولكن هذا كله يجتمع لك في ابنه، فقام الربيع فقبّل عينه، وما زال يدسّ إلى المهدي مَن يخبره خبر عبد الله بن أبي عبيد الله.
وكان المهدي قد جدّ في طلب الزنادقة وغلظ في أمرهم، فقدم عليه بجماعة منهم في سنة ست وستين ومائة، وأحضر معهم وضاح الشروي، وعبد الله بن أبي عبيد الله، وكان أخذه في مكّة، وأدخل على المهدي، فقال: أزنديق أنت؟ قال: نعم …… فقال له المهدي اقرأ فقرأ: (تباركت وعالموك بعظم الخلق) فأشار الربيع على المهدي بمطالبة أبيه بقتله، فقال المهدي لأبي عبيد الله اضرب عنقه … فارتعد فقال له العباس بن محمد: يا أمير المؤمنين: شيخ كبير، وله حرمة، ويكفيك غيره ما أردته منه …… فأمر المهدي عبد الله بن أبي العباس الطوسي…. بقتله، فلما تنحى ليقتل صاح: يا أمير المؤمنين، التوبة، فتغافل عنه المهدي، فقال عافية بن يزيد القاضي: إنّه يعرض بالتوبة، يا أمير المؤمنين، فأقبل عليه المهدي، وقال: والله ما الله أردت بذلك، انزعوا عمامته وجئوا في عنقه … وأمضى عبد الله بن أبي العباس ما أمر به من قتله فقتل …)
وأحضر في جملة مَن أحضر من الزنادقة ابن لأبي أيوب، سليمان بن أيوب المكّي، فأقر بالزندقة وتاب، فقبل المهدي توبته وأمر بإطلاقه …) (1) .
وقد رأيت نقل النص كما ورد في الوزراء والكتاب على طوله - رغم حذف بعض ما لا فائدة من ذكره - لأنّه يكشف لنا عن أُمور لو أردت الحديث عنها والاستشهاد بها - مع غيابه - لرجعت إليه وأثبت ما يخصّها منه أو لاتهمتني بالمبالغة والتحامل على هؤلاء (المؤرّخين).
فهذا النص يكشف عن عمق الصراع بين أطراف السلطة وحاشية الخليفة. وأنّ هذا الصراع الذي ربّما غذاه الخليفة نفسه، يمضي في غير حدود، بل ليس له حدود قبل سحق الخصم والقضاء عليه والانتهاء منه. لا يهم الوسيلة المستعملة. فهو ليس صراع فرسان وإنّما صراع يعتمد المؤامرات والدسائس، واللجوء إلى ما لا يجوز قبل اللجوء إلى ما يجوز.
أرأيت كيف يتحوّل الإنسان إلى لا إنسان عندما يسمح للشر أن يغلبه ويسد المذاهب عليه إلاّ ما يظنّه يشفي غيظه ويطفئ حقده. فهو دائم التفكير ليله ونهاره في هذا الخصم الذي يريد أن يثأر منه ويقهره ويدفنه بيديه حتى لا رجعة فيه.
نظر الربيع وأطال النظر فلم يجد في خصمه منفذاً يؤتى منه، فهو كفء غير متهم في كفاءته، وهو نزيه لم تعلق به شبهة وعفيف لم يذكر بما يثلم عفّته وموالٍ لم يعرف عنه خلاف.
ما الذي سيفعل إذن ومَن أين سينفذ لأبي عبيد الله وقد حصن نفسه فلا مطعن فيه.
لكن الربيع صمّم على الانتقام ولا بد منه، وها هو قد وجد الوسيلة إليه ووجد معها إذناً صاغية من المهدي.
هناك ابن لأبي عبيد الله وهو متّهم بالزندقة، أو من يستطيع الربيع أن يخيفه أو يطمعه فيتهم ابن أبي عبيد الله.
____________________
(1) الوزراء والكتّاب ص153 فما بعدها.
ولم يتردّد الربيع. فماذا عليه أن يقتل الابن البريء بالأب الذي أساء إليه يوماً، ما دام ذلك سيطفئ حقده. وما أكثر الأبرياء الذين قُتلوا قبله وبعده.
لكن الربيع ومعه الخليفة (المهدي) قد تجاوزا الحدود حين أرادا قتل الابن بمحضر من أبيه، ثم تجاوزا كل الحدود حين طلبا من الأب أن يتولّى بنفسه قتل ابنه، حتى ارتعد الأب، وحتى رقّ له أحد الحاضرين للاحتفال بالقتل!! فسأل (أمير المؤمنين) أن يعفيه ممّا لا يطيقه ولا يطيقه أب، ويقوم غيره بقتل الابن المتهم الذي لم ينفعه طلب التوبة وتنبيه القاضي للخليفة بأنّ المتهم أعلن توبته ولا مكان لقتله بعدها.
فأنت تحس بوضوح أنّك لست أمام متهم مطلوب تنفيذ حكم الدين فيه، وإنّما المطلوب من هذا القتل تعذيب شخص آخر به وإذلاله والانتقام منه وملاحقته بالإذلال والانتقام، بعد قتل ابنه أمامه.
وهذا ما ستراه بوضوح أكثر فيما أعقب قتل الابن. فيبدو أنّ الربيع لم يكتف بما فعله حتى الآن مع أبي عبيد الله فيضيف الجهشياري (ولمّا قتل المهدي عبد الله بن أبي عبيد الله قال الربيع لبعض خدم المهدي: لك عليّ ثلاثة آلاف دينار، إن فعلت شيئاً لا يضرّك، قال له وما هو؟ قال: إذا دخل أبو عبيد الله إلى المهدي فصار بحضرته، قبضت على سيفه، ومشيت إلى جانبه، فسينكر ذلك عليك أمير المؤمنين، فتقول: يا أمير المؤمنين، قتلت ابنه بالأمس، فكيف أمنه عليك أن يخلو بك ومعه سيفه اليوم! ففعل ذلك الخادم، فكان ذلك ممّا أوحش المهدي من أبي عبيد الله).
فهل رأيت مثل هذا الحقد لا يشفيه حتى القتل. ولا يكفيه ما حلّ بأبي عبيد الله ممّا دبّره الربيع، فهو يتابعه ويرشو خادم الخليفة بأن يثير لديه الشك من أبي عبيد الله والخوف منه على حياته إذا دخل عليه وسيفه معه ممّا أوحش المهدي من أبي عبيد الله.
ونهاية القصّة لا حاجة إلى ذكرها.
فابن أبي عبيد الله لم تقتله الزندقة؛ لأنّه كان زنديقاً، وإلاّ لقتلت ابن سليمان بن أيوب الذي جيء به معه بنفس التهمة. فلماذا أطلق هذا فلم يصبه سوء وقتل ذاك رغم إعلانه عن توبته وإعلام المهدي بها. ولقتلت أيضاً داود بن روح بن حاتم وإسماعيل بن مجالد ومحمد بن أبي أيوب المكي ومحمد بن طيفور حين جيء بهم بتهمة الزندقة فلم يقتلهم المهدي وإنّما استتابهم وخلى سبيلهم (1) .
هذه السياسة، وما تخلقه من عداء وما تثيره من صراع، هي التي قتلت عبد الله أو محمداً كما يسمّيه ابن النديم، وهي التي ستقتل أبرياء آخرين كما سنرى، بتهمة الزندقة سلاحاً يجرّده صاحب السلطان حين يغضب ويغمده حين يرضى. وما من أحد يستطيع تجنّبه؛ لأنّه ما من أحد يعرف ما هو.
____________________
(1) الطبري أحداث 166 ج8 ص163 ابن الأثير ج5 ص253.
الفصل ال عاشـر:
عبد الله بن المقفّع
وابن المقفّع، هذا المفكّر الأديب الكبير، هل كانت دار عاتكة حقاً وراء اتهامه بالزندقة، كما تذهب إلى ذلك الرواية المشهورة وهي تتحدث عن نهايته.
ولكن ما لعاتكة هذه ولابن المقفّع، وهي قد سبقته بسنين، وعاشت في الشام وعاش في العراق، ولم ير أحدهما الآخر ولم تربطهما علاقة حب؛ فيمنع نفسه المرور على دارها ويتحاشى الوقوف عندها، تجنبّاً لما يمكن أن يتعرّض له من سعي الوشاة والأعداء، وهي أميرة بنت أمير أو خليفة، لا تؤمن المخاطرة معها.
كيف كانت إذن عاتكة هذه سبب زندقة ابن المقفّع، ولم تكن هي زنديقة ولم تره ولم يرها، ولم يذكرها بشر ولا بخير؟!
تقول الرواية إنّ ابن المقفّع بعد أن أسلم مرّ في أحد الأيام ببيت النار، وهو معبد للمجوس فتمثّل ببيتين للأحوص بن محمد الأنصاري الشاعر الأموي المعروف، يذكر فيهما دار عاتكة التي يتعزّلها ويخشى المرور بها والوقوف عندها، بعد أن هُدّد في ذلك ومُنع منه. لكن صدوده عنها لم يكن عن قلّة وفاء أو سلوّاً كما قد يتصوّر، فما يزال فؤاده كما كان، موكّلا بها مقيماً على حبّها لا يتعزّ لها ولا يصد عنها إلاّ خوفاً على نفسه أو ربّما خوفاً عليها.
والبيتان من قصيدة طويلة في مدح عمر بن عبد العزيز وهما:
يا دار عاتكة التي أتعـزّل |
حذر العدى وبها الفؤاد موكّلُ |
|
إنّي لأمنحك الصدود وإنّني |
قسماً إليك مع الصدود لأميلُ |
ففسر تمثل ابن المقفّع بالبيتين على أنه حنين إلى دينه القديم ورجوع عن الإسلام.
بمثل هذه البساطة تعلّل وقائع التاريخ! وبمثل هذا الغباء يكتب، ثم يراد منّا أن نقنع بما يعلّل ويكتب.
وابتداءً ألاحظ أنّ المجوسية لم تكن من بين الوجوه المعروفة للزندقة إلاّ إذا خلطنا بين ما هو مجوسي وبين ما هو مانوي او مزدكي.
وكان ابن المقفّع مانوياً لا مجوسياً ليحنّ إلى بيت النار الذي يقدّسه المجوس.
ثم إنّ ابن المقفّع لم يُكره على الإسلام وإنّما أسلم طوعاً واقتناعاً. وكان يستطيع أن يبقى على دينه القديم - ولنفترضه المجوسية - فلا يحتاج إلى اعتزال بيت عاتكة، مع إمكان المرور به كغيره من أبناء ملّته، دون خوف من عدو أو رقيب.
ولأفترض أنّ ابن المقفّع لم يسلم إلاّ مجبراً، أكان مجبراً أيضا أن يتمثّل بالبيتين على ملأ من الناس وبصوت يسمعه هؤلاء وينقلونه؟ ألم يستطع أن يقولهما همساً أو دون الهمس يجريهما في خاطره وهو يمر ببيت النار، من غير صوت أو من غير صوت مسموع على الأقل، وليس أمامه شخص يريد أن يسمعه قوله فيه. إنّما كان يعبّر عن ماضٍ يحسّه ويتذكّره لا يقدر على إعادته أو العودة إليه. وكل ذلك في داخله لا يحتاج إلى الإعلان عنه، بل لا يريد الإعلان عنه أو إسماعه مَن لا يأتمنه، وقد كان من الفطنة والذكاء والاحتياط بحيث لا يغفل عما ينتظره لو نقل عنه تمثّله بالبيتين، مع كثرة أعدائه والحاسدين والساعين للإيقاع به، ومع كثرة الدماء التي سالت بسبب أو بدون سبب على قرب منه.
ولكن لماذا الاتهام والقتل بالزندقة هنا؟ لِمَ لم يتهم ابن المقفّع بالردةّ، وتطبّق عليه أحكام الارتداد كما تطبّق على أي مسلم ترك الإسلام إلى غيره؟! وهذا ما فعله ابن المقفّع، حين رجع الى مجوسيّته - كما يقولون - بعد أن أسلم. وهو ما يستدعي تنفيذ الحكم الخاص بالمرتدين، فذلك أحرى أن يمنح السلطة غطاءً شرعياً لا نزاع فيه. لكن السلطة، كما تثبت كل الوقائع، لا تهتم بهذا الغطاء ولا تفكر فيه، حين يقودها الحقد أو حين ترى أنّ مصلحتها يمكن أن تتعرّض لخطرٍ ما.
فهل سمعنا أنّ مجلساً انعقد لمناظرة ابن المقفّع، فأقيمت عليه البيّنة بالرجوع إلى دينه القديم والردّة عن الإسلام، خصوصاً وأنّ تمثّله بالبيتين لم يكن أمام مَن له الحكم خليفة أو قاضياً أو والياً، وإنّما نقلاً عن شخص أو أشخاص لم تورد الرواية أسم واحد منهم.
هذا إلى أنّ الرواية لا تقول أنّ ابن المقفّع قد ارتدّ عن الإسلام، أو عاد إلى دينه القديم. كل ما تقوله أنّه تمثّل ببيتي الأحوص المذكورين عند مروره ببيت النار.
أكان اتهام المسلمين وقتلهم هيّناً إلى هذا الحد، فيُتهم المسلم و يُقتل لتمثّله ببيتي شعر يحفظهما ويتناقلهما صغار المتأدّبين من رواته، ولم يكن في ذلك الوقت مَن لا يروي الشعر أو شيئاً منه؟!
رحم الله عاتكة وغفر لها، فلولاها لما تعرّض عبد الله بن المقفّع للاتهام بالزندقة وللقتل، في رواية نسجها بعض المتخلّفين، ولما أضعنا في تفنيدها ودحضها وقت القارئ ووقتنا.
تلك واحدة من التهم الموجّهة إلى ابن المقفّع لإثبات زندقته واستحلال دمه.
وتهمة أُخرى تتداولها الألسن منذ عهدٍ بعيد، وهي هذه التي تتعلّق بمعارضته للقرآن. ولقد أثارها وناقشها وفنّدها الكثيرون.
فقد زعم بعضهم أنّ ابن المقفّع عارض القرآن، حتى إذا وصل إلى قوله تعالى: ( حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ... ) قال هذا ما لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله، فترك المعارضة وخرق ما كان اختلقه.
وزعم بعضهم أنّ الآية التي مزّق ابن المقفّع بسببها ما كتبه في معارضة القرآن هي: ( وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ) .
بل زاد بعضهم فزعم أنّ ابن المقفّع سمع صبيّاً يقرأ هذه الآية فترك المعارضة!
وكلا الآيتين من سورة هود.
ولقد ساءني وأحزنني هذا القلم الذي تمسك به أصابع لا يحرّكها فكر ولا عقل؛ لأنّ صاحبها لا يملك الفكر والعقل، أو لا يحرص على الاستعانة بهما فيما يريد الكتابة فيه.
هل تصوّر هؤلاء أنّ عبد الله بن المقفّع كان يحاول معارضة القرآن أو أنّه عارضه فعلاً، ومضى في ذلك، حتى إذا وصل إلى واحدة من هاتين الآيتين، شعر بالعجز وتوقّف ومزّق ما كتب، معلناً عجزه واعترافه به.
ولا أدري ما الصعوبة في هاتين الآيتين، لمَن عارض ما سبقهما من آيات في هود، ومن سور قبل هود!!
ولقد تساءلت مراراً، وأنا أقرأ هذا الهذيان، وما أكثره، كيف استطاع هؤلاء الحمقى أن يكونوا مؤلّفين وأعلام، يُؤخذ عنهم ويُروى هذيانهم.
وتذكّرت حديثهم عن معارضة النبيين طليحة ومسيلمة للقرآن.
فقبل ابن المقفّع كانت تهمة معارضة القرآن قد لحقتهما: الأوّل بالفرسين الأدهمين وفارسيهما من بني نصر بن قعين. والثاني بكلامه عن الضفدعة ذات النقيق.
وضحكت؛ إذ كان الأمر في نظري لا يستحق أكثر من الضحك، وأنا أسمع نقيق الضفدعة، يرويه المؤرّخون، ويصدّقه القرّاء، في معارضة القرآن.
وعدت إلى ابن المقفّع - وإن كان هناك مَن يسمّيه ابن المقفّع بكسر الفاء - والتهمة الجديدة التي وجّهها إليه حرّاس الدين!! وهم طبعاً غير حرّاس الثورات في أيامنا هذه. وإن كانوا يلتقون معهم في تشديد الحراسة على الفكر.
ورأيتني أتوقّف طويلاً عند ما سمّي بـ (معارضة) القرآن. فمعارضة القرآن ليست ترجمة له ولا محاكاة لما جاء به. وإنّما الإتيان بمثله أو بما يقاربه، في المعنى وفي البيان، وفي علم ما كان والكشف عما سيكون، وهو المعجز في هذا كله.
وتساءلت: كيف كانت معارضة ابن المقفّع للقرآن، وأيّ سبيل سلك فيها؟
هل جرى حسب تسلسل سوره وآياته، فبدأ بسورة البقرة فآل عمران فالنساء... الخ؟
وهل اختار لها نفس الأسماء أم أسماء معاكسة - ليثبت معارضته - فسورة البقرة عنده، سيكون اسمها سورة الثور، وسورة النساء، سورة الرجال وهكذا؟!
وهل تحدث في كل سورة عمّا تحدث القرآن، أم خالف ما جاء به في تلك السور، أم ذهب مذهباً خاصاً لا شأن له بما ورد في القرآن؟!
ثم لماذا لم يستطع ابن المقفّع معارضة (فوران التنّور) أو (بلع الماء) في سورة هود، وقد عارض عشراً من سور القرآن قبله، وعدداً أكبر من آيات هود، قبل التنّور وبلع الماء، وليس في القرآن ما هو أبلغ من بعض أو ما هو دون بعض. ولا في هاتين الآيتين من سورة هود ما لا يمكن معارضته، لمَن عارض كل السور والآيات قبلهما؟!
وماذا بشأن ما تمّت معارضته من القرآن، وهو جزء غير يسير (عشر من طوال السور، وثلث من سورة هود)؟
ألم يحفظه أحد أو يحتفظ به أحد من هؤلاء الزنادقة من أصحاب ابن المقفّع، يؤيّدون به مذهبهم. أو من أعدائه يؤيّدون به اتهامهم ويتسلّحون به في مهاجمتهم له ومطالبتهم برأسه أو تبرير قطع رأسه، وإن كان قطع الرأس أو الرؤوس في ذلك العهد، لا يحتاج إلى تبرير.
ولأفترض أنه لم يستطع معارضة آيتي (التنور) و (بلع الماء). فماذا عليه لو أغفلهما فلم يأت بمثلهما ولا بعكسهما؟!
أكانت معارضته ستكون ناقصة وستفقد قيمتها، لو جاء بقرآن ذي مائة واثنتي عشرة سورة، بنقصان سورتين عن سور القرآن، التي تبلغ مائة وأربع عشرة. أم كان أصحابه سيغضبون ويشكّون في قرآنه الذي نقص آيتين عن قرآن محمد؟!
ما أظن ذاك، وما أظن أصحابه من قلّة الأدب وقلّة الوفاء بحيث يجفون صاحبهم ويغضبون عليه بسبب آيتين فقط من قرآن كامل!!
ثم متى كانت معارضة ابن المقفّع للقرآن؟ إنّ الذين يتحدثون عن معارضته، يتحدثون عنها بعد إسلامه طبعاً.
فكيف لمَن أسلم حديثاً، أن يبدأ دينه الجديد بمعارضته وتحدّيه، فيثبت عليه تهمة ما كان أغناه عنها لو بقي على دينه القديم، كواحد من هؤلاء المجوس وغير المجوس الذين لم يسلموا، ولم يعرّضوا أنفسهم للقتل بتهمة الزندقة.
فهل أسلم ابن المقفّع ليحفظ حياته وينتفع بإسلامه ويرضي فكره ووجدانه، أم أسلم ابتغاء القتل واستعجالاً له؟!
وقد أضيف إلى كل ما سبق، أنّ الذين عارضوا القرآن قبل ابن المقفّع، كانوا - كما يقول المؤرّخون - يدّعون النبوّة، لكنّنا لم نجد أحداً منهم اتهم ابن المقفّع بدعوى النبوّة. فهل قصد ابن المقفّع من معارضة القرآن تحمّل مخاطره، وبينها وربّما أوله، المخاطرة بحياته، إظهار بلاغته، وهو لم يكن في حاجة لذاك، إذ لم تكن بلاغته موضوع نزاع أو شك. وكان - وهو حي - من أشهر بلغاء عصره.
بعد هذا، فإنّ قتل ابن المقفّع كان في النصف الأوّل من القرن الثاني الهجري عام 142، ولم تُثر تهمة معارضته للقرآن، ولم تُعرف وتنتشر إلاّ بعد مدة طويلة على قتله.
فكيف خفيت مثل هذه التهمة، لو صحّت، مع كثرة أعدائه والساعين به. وكان قتله بها أسهل وأقوى في تبرير القتل بحجّة لا يمكن دفعها والطعن فيها.
أظنّني لن أحتاج إلى أكثر من هذا في تفنيد تهمة لا تقوم أصلاً للحجاج والنقاش. وحرام على وقت وجهد يضيعان فيها وفي أمثالها.
وأظن من الخير للقارئ الكريم، أن أنتقل به إلى الجِد في موضوع ابن المقفّع وأسباب قتله، بعد حديث لا جِدّ فيه، بل عبث وغباء.
كان عبد الله بن علي، عمّ المنصور، قد دعا إلى نفسه بالخلافة بعد وفاة أبي العباس السفّاح رافضاً خلافة المنصور، الذي بعث إليه بجيش يقوده أبو مسلم الخراساني.
ونشب بين الطرفين قتال أسفر عن هزيمة عبد الله ولجوئه إلى أخويه عيسى وسليمان في البصرة، وسليمان عامل عليها يومئذ.
وسعى الأخوان عيسى وسليمان بكل الوسائل للعفو عن أخيهما، وتم الاتفاق أخيراً على إعطائه الأمان، الذي يبدو أنّ المنصور لم يكن راغباً فيه؛ فأرسل سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب ليضغط عليهما ويدفعهما إلى الشخوص بعبد الله إليه.
وذهب عيسى وسليمان استجابة لطلب المنصور أو لضغطه، ومعهما عبد الله.
وحين خرجا كان عبد الله قد اقتيد إلى محبس في قصر المنصور بقي فيه حتى وفاته عام 147 في قصته التي يرويها المؤرّخون.
ولكن ما شأن ابن المقفّع بكل ذاك.
لقد كان ابن المقفّع كاتباً لعيسى بن علي، وهو الذي تولّى كتابة الأمان لعبد الله حين تمّ الاتفاق عليه مع المنصور.
وقد اجتهد ابن المقفّع في صياغة هذا الأمان محترساً من أيّ تأويل يمكن أن ينفذ منه المنصور للإيقاع بعبد الله.
وزيادة في الحيطة والحذر، فقد ضمن كتاب الأمان عبارات أحفظت المنصور، وبلغت به من الغيظ كل مبلغ حتى طلب من يكفيه ابن المقفّع.
وكان سفيان بن معاوية يحقد على ابن المقفّع ويكرهه أشدّ الكره لأسباب يردّدها المؤرّخون وليس هنا محل ذكرها.
وعرف ما يضمره المنصور لابن المقفّع وأنّ قتله سيسره ويقع منه أحسن موقع، إن لم يكن المنصور نفسه قد أغراه بقتله وأمنه من عواقبه.
وواتته الفرصة للثأر منه حين أرسل عيسى بن علي عبد الله بن المقفّع في بعض أُموره إلى سفيان هذا.
ولم ينفع بن المقفّع احتياطه وطلبه من عيسى عدم إرساله وحده وأن يكون بصحبة شخص آخر حدّده بالاسم. فحين دخل ابن المقفّع أخذه اثنان من رجال سفيان وأوثقاه، ثم بدأا بتقطيعه عضواً عضواً وإلقاء كل عضو يُقطع في تنّور مسجور حتى انتهيا منه.
وهكذا انتهت حياة هذا الأديب الكبير.
لم تقتله الزندقة - على افتراض صحّة اتهامه بها - بل قتلته السياسة. قتله كتاب الأمان الذي كتبه لعبد الله بن علي المطالب بالخلافة بعد السفّاح. ذلك أنّ المنصور لم يغفر لعبد الله خلعه له ودعوته الناس إلى بيعته بالخلافة والحرب التي قامت بينهما، وما كان يمكن أن تنتهي إليه لو لم ينتصر جيش المنصور فيه. ثم خوف المنصور - لو عفا عنه وتركه - أن يعاود الثورة عليه، وهي ليست مأمونة النتائج دائماً.
وهذا ما يفسّر حبس المنصور له بعد الأمان مباشرة، ثم تسليمه إلى عيسى بن موسى وطلبه منه أن يقتله عند حج المنصور سنة 147، وحين عاد من حجّه ووجد عيسى لم ينفّذ أمره بقتله؛ أعاده إلى الحبس في بيت أساسه ملح كما يقول المؤرّخون، وأجرى في أساسه الماء فسقط البيت على عبد الله وقتله.
ولم يكتف المنصور بمقتل عبد الله، بل تجاوز ذلك إلى سليمان نفسه عم المنصور وأخي عبد الله، إذ عزله عن البصرة وولّى مكانه سفيان بن معاوية عدو ابن المقفّع وأكره الناس له.
فأنت ترى حنق المنصور وشدّة غيظه من عبد الله بن علي ومحاولاته قتله حتى تمّ له ذلك، رغم كتاب الأمان الذي أعطاه له. وعبد الله عمّه من حيث النسب ومن سادات آل العباس. واللذان سعيا في أمره وتوسّطا له عمّاه عيسى وسليمان. وعبد الله بعد، هو الذي حارب مروان بن محمد آخر خلفاء الأمويين وغلبه حتى ألجأه إلى مصر حيث تولى صالح بن علي أخو عبد الله قتله في بوصير.
فكيف سيسكت عمّن كتب له كتاب الأمان هذا وحاول أن يحصره فيه ويضيّق عليه ويسد الطريق أمامه للتخلّص من عبد الله.
لقد رأى المنصور فيما عمله ابن المقفّع تحدّياً له ولسلطانه. وإذا كان قد قتل عمّه وأحد مؤسّسي الدولة التي أصبح هو خليفتها، أكان سيتحرّج عن قتل واحد ممّن لا ينتسب إلى بيت رفيع من بيوت العرب، ولا تحميه قبيلة معروفة من قبائل العرب، ولا يخشى بسببه تمرّداً أو انتفاضاً في جزء من أقطار الخلافة. ولا يعدو أن يكون واحداً من هؤلاء الموالي الذين لا يملكون غير القلم، اسمه عبد الله بن المقفّع.
ويمكن أن أضيف إلى ما أثار المنصور ضد ابن المقفّع ودفعه للقضاء عليه: نقد ابن المقفّع الذي ضمّنه رسالة الصحابة في سياسة الحكم، والتي تعرّض فيها بالنقد الخفي حيناً والواضح حيناً واللاذع دائماً لرأس السلطة الخليفة المنصور: (سلطان الله في أرضه) كما يقول عن نفسه.
الفصـل ال حادي عشـر:
صالح بن عبد القدوس
يقول عنه ياقوت: (كان حكيماً أديباً فاضلاً شاعراً مجيداً كان يجلس للوعظ في مسجد البصرة ويقص عليهم) (1) .
ويقول ابن عساكر: (كان حكيم الشعر زنديقاً متكلّماً … وكان يعظ الناس بالبصرة ويقص عليهم …) (2) .
ويقول الذهبي: (صاحب الفلسفة والزندقة … كان يعظ الناس بالبصرة ويقص) (3) .
ويقول ابن شاكر الكتبي: (… كان حكيم الشعر زنديقاً متكلّماً …) (4) .
ويقول ابن حجر: (صاحب الفلسفة والزندقة …) (5) .
ويقول أبو الفرج: (كان بالبصرة ستة من أصحاب الكلام... وصالح بن عبد القدوس) (6) .
ويقول ابن النديم: (ومن رؤسائهم - يقصد المانوية - المتكلّمين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الزندقة: صالح بن عبد القدوس) (7) .
يتفق الذين ترجموا له أو ذكروه أنّه كان حكيماً متكلّماً فيلسوفاً، لكنّهم يضيفون أنّه قتل على الزندقة.
____________________
(1) معجم الأدباء، ترجمة صالح بن عبد القدوس ج12 ص6.
(2) تاريخ دمشق لابن عساكر ج6 ص371.
(3) ميزان الاعتدال، ترجمة صالح بن عبد القدوس ج2 ص297.
(4) فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج2ص116.
(5) لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ج3ص172.
(6) الأغاني ط دار الكتب ج3 ص146.
(7) الفهرست، نشر دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، ص473.
هو إذن حكيم متكلّم، لكنّ ذلك وحده لا يكفي فلا بد من تهمة - والزندقة جاهزة - تبرّر قتل هذا الذي تجرّأ فجلس للوعظ في مسجد البصرة ويقص على الناس ويحدّثهم. وإذا تعرّض للشعر فإنّ شعره لا يخلو هو أيضاً من موعظة وحكمة، وليس كهؤلاء الشعراء المجّان الزنادقة الذي يكاد شعرهم يقتصر على الخمر ومجالس اللهو والجواري والغلمان. تحميهم السلطة وتغض النظر عنهم وتجزل عطاياهم ما داموا هناك، بعيدين عن السياسة والحكم، بعيدين عن الناس وواقعهم المثقل بالهم والأسى، بعيدين عن كل ما يمكن أن يزعج السلطة ويثير المشاكل أمامها. لا يهم بعد أن يكونوا زنادقة أو مؤمنين عرباً أو موالي، مستهترين أو متزمتين.
لم يكن صالح من هؤلاء، أو لنقل لم يكن نشاطه كنشاط هؤلاء، محبوساً على الخمر ومجالس اللهو والجواري والغلمان، بل كان صاحب فكر وحكمة، وحين يقص على الناس في مسجد البصرة فلا بد أن يصدر في قصصه ووعظه عن فكر وحكمة، ولا بد أنّه كان يتناول في قصصه ووعظه بعض مشاكل الناس ومواقف السلطة، ولو من بعيد.
ولم تكن السلطة لتحتمل موقفاً كهذا مهما رقّ ولان، فلا شيء يقلقها ويغيظها أكثر من أنّك تعض الآخرين وتنبّههم إلى ما هم فيه، وإلى ما يمكن أن يكونوا فيه، وتدعوهم عن أي طريق - لا عن طريق الوعظ والقصص وهو أسهل الطرق وأسرعها نفاذاً إلى القلب - لمحاولة إصلاح أو تغيير.
ولا بد أن تكون أخبار صالح قد بلغت المهدي وأثارته. وربّما كثر فيه، وربّما بولغ فيما نقل إليه منه. وكان قليلها كافيا لأن ينتهي بصاحبها إلى ما انتهى إليه.
وهذا ما دعا المهدي إلى إحضاره، وهو في ذلك الوقت شيخ كبير.
وسأله المهدي عمّا اتهم به من الزندقة فنفى التهمة عنه وأعلن براءته منها.
وكان ذلك كافياً لإطلاقه، كما أطلق عدد من المتهمين بالزندقة بعد نفيهم التهمة عنهم وإعلان براءتهم منها.
لكنّ الزندقة لم تكن هي التي أثارت المهدي وغاظته، ليطلقه كما فعل مع الآخرين بل السياسة والوعظ والقصص في مسجد البصرة.
ولهذا فحين لم يجد المهدي حجّة يقتل بها ابن عبد القدوس الذي تهيّأ للخروج من مجلسه وخطا أُولى خطواته، تذكّر المهدي أو ذكر أنّ له بيتاً من الشعر يقول فيه:
والشيخ لا يترك أخلاقه |
حتى يوارى في ثرى رمسه |
فتعلّق المهدي بهذا البيت وقال له كما يذكر المؤرّخون: (فأنت لا تترك أخلاقك ونحن نحكم فيك بحكمك في نفسك، ثم أمر به فقتل وصلب على الجسر).
وليس في هذا البيت كفر أو زندقة ولا ما هو قريب من الكفر والزندقة، وليس فيه سب ولا قذف ولا ازدراء بالدين ولا بفرض من فروضه. مع أنّ المهدي لم يقتل مَن سبّ وقذف من الشعراء ومَن ازدرى بالدين وبفروضه.
إنّ كل ما يتضمّنه البيت لا يعدو حكمة وتجربة إنسانية ومعنىً يتداوله الشعراء وغير الشعراء منذ القديم.
ولم يكن المهدي في حاجة إلى هذا البيت لتنفيذ ما عزم عليه من قتل صالح، فلو كان صالح قد ثبتت عليه الزندقة فإنّ قتله سيكون بها لا بالبيت، قاله أم لم يقله، أما وقد نفاها عنه وأعلن براءته منها، ولم تثبت عليه حتى بشهادات الزور التي كانت سوقها رائجة في ذلك الوقت. فلم يكن أمام المهدي من وسيلة يتخلّص بها من صالح، غير اللجوء إلى هذا البيت الذي ليس فيه - على كل حال - ما يحل دم امرئ مسلم كما قلت.
ولقد عجب ابن المعتز وهو يعرض لصالح بن عبد القدوس في طبقاته، كيف يكون صالح زنديق، و ليس لأحد ما لصالح هذا في الزهد في الدنيا والترغيب في الجنّة، والحث على طاعة الله، وذكر الموت والقبر كما يقول، واستشهد بأبيات صالح في هذا.
لكنّ الذي فات ابن المعتز أن لو جعل صالح كل شعره: زهداً في الدنيا، وترغيباً في الجنّة، وحثّاً على طاعة الله، لما نفعه ذلك ولما عدل في نظر المهدي بيت (الشيخ).
وهكذا يذهب صالح بن عبد القدوس ضحيّة بيت من الشعر حوّلته السياسة إلى سيف قطعت به رأسه.
الفصـل ال ثاني عشـر:
عبد الكريم بن أبي العوجاء
لا تمدّنا المصادر التي بين أيدينا بشيء ذي بال عن عبد الكريم بن أبي العوجاء، فهي لا تحدثنا مثلاً عن نشأته وبيئته وعائلته ومصادر ثقافته ونشاطه قبل أن تُضرب عنقه، مع أنّها تقرنه دائماً بالزنادقة المعروفين في عهده حين تتحدث عنهم: كبشّار، وصالح بن عبد القدوس، ومطيع بن إياس،÷ وحماد عجرد، ووالبة بن الحباب، وسواهم.
فلا أبو الفرج ولا الخطيب البغدادي ولا ابن خلكان ولا ياقوت ولا غيرهم، من أصحاب التراجم، ذكروه فيمَن ترجموا لهم.
ولا المؤرّخون: كالطبري، والمسعودي، وابن الأثير.
ولا تجد له إلاّ اسماً مجرّداً أحياناً أو مضافاً إلى خبر لا يمكن أن يعطيك صورة عن الرجل وعن حياته العقلية.
وعليك أن تجهد في ضمّ هذه الأخبار القليلة المتفرّقة إلى بعضها لعلّك تصل من خلالها إلى بعض ما تريد، مع أنّ الرجل كان كما يبدو، متكلّماً ذا شأن ولم يُقتل لولا ما كان له من شأن (1) .
ولنعد إلى هذه الأخبار القليلة عنه، وأوّل ما يطالعنا منها: أنّه عربي صليبة من بكر بن وائل، وأنّه خال معن بن زائدة واسمه عبد الكريم بن نويرة.
فإذا تجاوزت الاسم والقبيلة فإنّك ستعبر مسافة زمنية طويلة لن تتوقّف فيها إلاّ عندما أيقن بالقتل فاعترف بأنّه وضع أربعة آلاف حديث لم يعترف بوضعها إلاّ حينذاك!!
____________________
(1) يقول أبو الفرج في ج3 ص146 من الأغاني ط دار الكتب عند ترجمته لبشّار: (كان بالبصرة ستة من أصحاب الكلام عمرو بن عبيد، وواصل بن عطاء، وبشار الأعمى، وصالح بن عبد القدوس، وعبد الكريم بن أبي العوجاء، ورجل من الأزد - قال أبو أحمد: يعني جرير بن حازم - فكانوا يجتمعون في منزل الأزدي ويختصمون عنده...) ومن هذا يظهر أنّ ابن أبي العوجاء كان من أصحاب الكلام المعروفين بالبصرة ومن مستوى الذين كان يختصّم معهم في مسائله.
يقول الشريف المرتضى في القسم الأوّل من أماليه ص137: (فأمّا ابن أبي العوجاء فقد ذكرنا ما روي من اعترافه بدسّه في أحاديث النبي (ص) أحاديث مكذوبة.
ويتناول نشوان بن سعيد نفس الموضوع في الحور العين ص193 فيقول: (ومنهم - يعني الزنادقة - عبد الكريم بن نويرة الذهلي وهو الذي سير عن رسول الله (ص) أربعة آلاف حديث كذباً فقتله محمد بن سليمان بن علي بالكوفة، وصلبه فقال للمسلمين حين أحسّ بالقتل اعملوا ما شئتم فقد لبست عليكم دينكم وجعلت حلالكم حراماً وحرامكم حلالاً، ودسست عليكم في كتبكم أربعة آلاف حديث كذباً …).
ويذكر الذهبي في ميزان الاعتدال ج2 ص644 في ترجمة ابن أبي العوجاء أنّه (خال معن بن زائدة زنديق معتر؟ قال أبو أحمد بن عدي: لما أُخذ لتُضرب عنقه قال: لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرّم فيها الحلال وأحلّل الحرام. قتله محمد بن سليمان العباسي الأمير بالبصرة).
ولا يتجاوز ابن حجر في لسان الميزان مَن سبقه إلاّ بإضافة أخطأ فيها إذ يقول: (لما أُخذ - يعني عبد الكريم بن أبي العوجاء طبعاً - لتُضرب عنقه قال: لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرّم فيها الحلال وأحلّل الحرام. قتله محمد بن سليمان العباسي الأمير بالبصرة).
(وكان عبد الكريم يفسد الأحداث فتهدّده عمرو بن عبيد فلحق بالكوفة فدل عليه محمد بن سليمان فقتله وصلبه، وذلك في زمن المهدي …).
وإذا كان ابن حجر ينقل ما سبق إليه الآخرون من خبر عبد الكريم فإنّه يخطئ فيما يضيفه عن تهديد عمرو بن عبيد له؛ ذلك أنّ عمراً توفّى عام 144 قبل خلافة المهدي بأربع عشرة سنة، وقبل مقتل ابن أبي العوجاء بعشرين سنة أو تزيد، فمن غير المعقول أن يبقى ابن أبي العوجاء مختفياً في الكوفة كل هذه المدّة لم يدل عليه لو كانت السلطة تريده، مع أنّ الكوفة لا تبعد شيئاً عن مركز الخلافة: بغداد، بل هي أقرب إليها من البصرة التي هرب منها.
وأظن ابن حجر نقل الخبر عن أبي الفرج الذي ما نراه إلاّ قد أخطأ هو الآخر فيه (1) .
وأعود إلى حديث ابن أبي العوجاء، بعدما رأيت المترجمين له يكادون ينسخون عن بعضهم فيما يتناولون من شأنه، فما هي تهمته وفيم كان مقتله؟
____________________
(1) الأغاني، طبعة دار الكتب ج3 ص147.
هل لأنّه وضع أربعة آلاف حديث ونسبها إلى النبي كما يقولون؟
ما أظن فابن أبي العوجاء لم يعترف بوضع تلك الأحاديث إلاّ حين أُخذ لتُضرب عنقه وأحسّ بالقتل، كما تؤكّد النصوص التي سمعناه، وليس قبل ذلك.
ما هي التهمة إذن؟ الزندقة؟ ولماذا لم تقتل هذه التهمة غيره من أصحابه الذين شهروا بها كأبي نواس وواليه ومطيع وحماد ويونس، وكانوا خلطاء لا يفترقون حتى في الزندقة.
لقد قتل من هؤلاء عبد الله بن المقفّع.
وقتل صالح بن عبد القدوس.
وها هو عبد الكريم بن أبي العوجاء يلحق بهم.
فماذا بين هؤلاء الثلاثة من جامع يفردهم عن أصحابهم ويجعلهم المقتولين دونهم.
أظنـه: الفكر
لقد كان ابن المقفّع مفكّراً، وكان صالح بن عبد القدوس مفكّراً، وكان عبد الكريم بن أبي العوجاء مفكّراً.
وليس من شيء يخيف السلطة أكثر من الفكر حين يبحث وينقد ويرفض.
قصر الآخرون من الزنادقة، كما يدّعون، نشاطهم على اللهو والخمر والمجون فنجوا وتركتهم السلطة في لهوهم وخمرهم ومجونهم أو شجعتهم وأذاعت ما ينظمون ويصورون في لهوهم وخمرهم ومجونهم.
وتجاوز ابن المقفّع وابن عبد القدوس وابن أبي العوجاء ما هو مسموح به من السلطة أو ما كانت تشجع عليه فكان القتل مصيرهم وسيلحق بهم بشّار.
أما الأربعة آلاف حديث التي يحاول الرواة أن يجعلوا منها السبب في مقتل ابن أبي العوجاء فليس فيها ما يقنع فنحن حتى اليوم لا نعرف منها واحداً نص عليه رجال الحديث بأنه من وضع عبد الكريم.
أين ما حلّله ابن أبي العوجاء ممّا حرّمه الإسلام؟ هل حلّل القتل أو الزنا أو السرقة أو شهادة الزور؟
لقد كانت هذه محرّمة قبل ابن أبي العوجاء وفي عصره وبعد عصره حتى اليوم؛ لم يشك في حرمتها أحد ولم يذهب إلى استحلالها أحد منذ حرّمها الإسلام.
وأين ما حرّمه ممّا حلّله أو أوجبه الله على عباده؟ ولأترك الصلاة والصوم والحج وغيرها من أركان الإسلام التي لا يجرؤ عبد الكريم ولا مَن هو أكبر منه على المس بها لا تحريمها، إلاّ إذا خرج جهاراً من الإسلام مبشّراً بدين جديد، وهو ما لم يفعله عبد الكريم. ولو فعله لوجد ألف سيف، قبل سيف السلطة تتوزّع لحمه.
ماذا حرّم ابن أبي العوجاء إذن في الأربعة آلاف حديث التي دسّها؟! هل حرّم صلة الرحم أو عيادة المريض أو مساعدة المحتاجين ممّا يدعو إليه الإسلام ويحث عليه؟!
ما الذي حلّل وما الذي حرّم في أربعة آلاف حديث، وكل الكبائر في الإسلام لا تتجاوز السبعمائة عند المكثر، ولا الثلاث أو الأربع عند المقل؟! لقد فتّشت كتب الحديث ومظانها، سنّيّة وشيعيّة؛ فلم أجد واحداً من المؤلّفين ذكر أنّ هذا الحديث أو ذاك قد رواه أو نقله ابن أبي العوجاء.
بل إنّ أربعة آلاف حديث تكفي وحدها لأن تؤلّف صحيحاً أو مسنداً يتناقله الناس ولو سرّاً، كما يتناقلون كتب الكفر وشعر الإباحة علناً، لو صحّ بما اتهم به عبد الكريم بن أبي العوجاء. ثم كيف استطاع ابن أبي العوجاء أن يسرِّب أربعة آلاف حديثاً بمتونها وأسانيدها، فلم يشعر به أحد ولم يكشف أحاديثه أو بعضها أحد، رغم شدّة احتراس الناس بالنسبة للأحاديث النبويّة وتدقيقهم فيها، خصوصاً وأنّ حركة تدوين الحديث كانت قد بدأت في ذلك العهد، وبدأ تمييز الأحاديث ونقدها وبيان صحيحها من موضوعها. هذا فضلاً عن أنّ القرآن والسنّة النبويّة الصحيحة التي توارثها المسلمون حتى عهد ابن أبي العوجاء، كانا كفيلين ببقاء الحلال حلالاً والحرام حراماً، وتحصينهما ضد محاولات عبد الكريم وغير عبد الكريم. وإذا كان حماد الراوية - وما أظنّه كان بعيداً عن الرواة وهم يتحدثون عن عبد الكريم ووضعه الأحاديث - قد أفسد الشعر بما يدس على الشعراء من قول لم يقولوه فيجوز لشدّة معرفته بلغات العرب ومذاهبهم في الشعر. فليس الأمر كذلك بالنسبة لحديث النبي، فحماد كان يضع البيت والبيتين وإذا زاد وضع القصيدة ونحلها شاعراً من شعراء العرب، وعددهم غير محدود ولم يعيشوا في زمان واحد. والوضع عليهم سهل لبعدهم عن العصر الذي عاش فيه حماد وعدم تدوين الشعر. أمّا حديث النبي فيختلف عن الشعر، يختلف عنه في أنّه كله لشخص واحد هو النبي محمد (ص). وسنّته قد سار عليها المسلمون من عهده رغم بعض الاختلاف، فلم يكن يسيراً على واحد - ولو كان في مثل معرفة حماد - أن يغيّر فيما جاءت به السنّة تحريماً أو تحليلاً، وقد عرفه المسلمون وساروا عليه وخضعوا له في حياتهم اليومية جيلاً بعد جيل قبل عبد الكريم بن أبي العوجاء. ومع ذاك فإنّ الأحاديث النبوية جاءت في قسم كبير منها لتفصيل ما في القرآن - وهو ما لا يمكن نسبة الوضع إليه - من حلال أو حرام لا لتحليل ما حرّم أو تحريم ما حلّل. فرواية الأربعة آلاف حديث، ما أحسبها إلاّ قد وضعت بعد قتل بن أبي العوجاء تبريراً لقتله واعتذاراً عن قاتله. وأنّ أخذه لم يكن بسبب هذه الأحاديث كما قدمت إذ إنّه لم يعترف بها، ولم يعلن عن وضعها بقول الرواة أنفسهم، إلاّ بعد ما جيء به وقُدّم لضرب عنقه بتهمة لا أشك أنّها غير ذات صلة بما يبرّر المؤلّفون قتله، فلم تكن قضيته، قضية حديث ومحدّثين، ولم يكن بين ممثّلي الادعاء فيه، ابن حنبل والبخاري.
الفصـل الثا لثعشـر:
بشّار بن بُـرْد
أظن عدوى الخوف من بشّار قد وصلتني عبر التأريخ، حتى وأنا أحاول الانتصاف له وتبرئته ممّا اتُهم به.
فما إن أمسكت بالقلم مبتدئاً حديثي عنه حتى تمثّل لي أبو معاذ - كما يصوّره المؤرّخون - بجسمه الضخم ووجهه العابس المتجهّم وخلقه الصعب، وهو يملأ فمه بهجاء الناس وثلب أعراضهم حقّاً وباطلاً بما فيهم وبما ليس فيهم. وخشيت أن ينالني منه ما لا قبل لي به، وقد خافه أهل عصره فاشتروا أعراضهم منه. ولست بشاعرٍ فيخشى لساني ولا صاحب مال فيطمع في مالي ولا سلطان فيرهب سلطاني. ثم مالي وللرجل أهيجه وقد كفّ نفسه عنّي فلم يعرض لي بما يسوء.
وتذكّرت أنّني الآن في القرن الخامس عشر الهجري وبيني وبينه قرون وقرون تحول بينه وبين أن ينالني بسوء، فما عليّ إذا أنا خضت في حديثه بما يرضيه أو لا يرضيه، ولن أحتاج أن أتملّقه كما فعل سلم الخاسر معه، ولن أحتاج إلى استئذانه فيما أقول عنه. فلأمض إلى ما أريد ولأهجه ما استطعت فلن يقدر على شيء منّي.
ولكن ما للقارئ ولهذه المقدمة فربّما لا يشاركني خوفي من بشّار ولا إشفاقي من هجائه، حتى لو رجع إلى عصر بشّار أو عبر بشّار القرون إلى عصرنا هذا.
عليّ إذن أن أعود لما أردت من الحديث عن بشّار، هل كان زنديقاً وهل قتل بسبب الزندقة؟
وقبل هذا السؤال وللإجابة عليه، أرى من الضروري أن أسأل متى قُتل بشّار وكم كان عمره عند ذاك.
يقول صاحب الأغاني إنّه قتل عام 168 وقد بلغ نيّفاً وسبعين سنة (1) .
أمّا الخطيب البغدادي (2) وابن خلكان (3) وعبد القادر البغدادي (4) فيذهبون إلى أنّه كان قد تجاوز التسعين عند قتله عام 167 أو 168.
____________________
(1) الأغاني طبعة دار الكتب ج3 ص249 ترجمة بشّار.
(2) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج7 ص118 ترجمة بشّار.
(3) وفيات الأعيان لابن خلكان تحقيق الدكتور إحسان عباس ج1 ص273.
(4) خزانة الأدب لعبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيق عبد السلام محمد هارون، نشر مكتبة الخانجي ج3 ص230 وهو ما يذهب إليه صاحب نكت الهميان في نكت العميان عند ترجمته لبشّار ص126
ويتفق الذين يترجمون له أنّه قال الشعر وهو ابن عشر سنين. وحين بلغ الحلم كان مخشي معرة اللسان كما يعبّر أبو الفرج.
فبشّار بقي يقول الشعر أكثر من ستين سنة على رواية المقل، وأكثر من ثمانين سنة على رواية المكثر. لم يترك باباً من أبواب الشعر إلاّ طرقه ونظم فيه. مدح وهجا وتغزّل وشبّب وفضل النار على الأرض وأفسد النساء فلم تتعرّض له السلطة ولم تسجنه، بل على العكس، كان المهدي - الذي قتله فيما بعد - يدنيه ويقرّبه ويطلب معاونته في قول الشعر، إذا تهيّأت مناسبة واحتاج إليه، أو حاوله في مناسبة ولم ينجح فيه.
يروي صاحب الأغاني: دخل بشّار على المهدي وقد عرضت عليه جارية مغنّية فسمع غناءها فأطربه، وقال لبشّار قل في صفتها شعراً، فقال:
وَرائِحَةٍ لِلعَينِ مِنها مَخيلَةٌ |
إِذا بَرَقَت لَم تَسقِ بَطنَ صَعيدِ (1) |
… الخ
ويروى: بعث المهدي إلى بشّار فقال له قل في الحب شعراً ولا تطل واجعل الحب قاضياً بين المحبين ولا تسمِ أحداً فقال:
أَجعَلُ الحُبَّ بَينَ حِبيّ وَبَيني |
قاضِياً إِنَّني بِهِ اليَومَ راضِ (2) |
… الخ
ويروي أنّه: دخل المهدي إلى بعض حجر الحرم فنظر إلى جارية منهنّ تغتسل، فلما رأته حصرت ووضعت يدها على … فأنشأ - يعني المهدي - يقول:
نظرت عيني لحيني
ثم ارتج عليه، فقال مَن بالباب من الشعراء؟ قالوا: بشّار فأذن له فدخل فقال أجز: نظرت عيني لحيني.
فقال بشّار:
نظرت عيني لحيني |
نظراً وافق شيني (3) |
____________________
(1) الأغاني ج3 ص188.
(2) الأغاني ترجمة بشّار ج3 ص222.
(3) الأغاني ترجمة بشّار ج3 ص230 وطبقات الشعراء لابن المعتز ص23.
ويمكنك أن تتصوّر البيتين التاليين له ممّا لم يذكره أبو الفرج وهو يكمل الحديث
(فقال له المهدي: قبّحك الله ويحك! أكنت ثالثنا! ثم ماذا؟)
فقال:
فتمنّيت وقلبي |
للهوى في زفرتين |
……
وأظنّك تستطيع بسهولة أن تكمل هذا البيت، أو تتوقّعه بما يتم معه منظر الجارية العارية، وهي تغتسل غافلة، والخليفة يرى ويراقب.
وها أنت ترى أنّ المهدي يطلب من بشّار أن ينظم أو يجيز ما نظم إذا ارتج على المهدي فلم يستطع أن يكمل ما بدأ به من نظم، في مناسبات فيها الجنس المكشوف، يستسلم له (أمير المؤمنين) ويدعو مَن يشاركه فيه.
والمهدي نفسه لم يكن بعيداً عمّا يتهم به بشّار من المجون والخلاعة واللهو.
فالطبري يصف المهدي فيقول: (وكان يعقوب بن داود قد عرف من المهدي خلعاً واستهتاراً بذكر النساء والجماع، وكان يعقوب بن داود يصف من نفسه في ذلك شيئاً كثيراً وكذلك كان المهدي …) (1) .
وهذا ما يؤكّده ابن الأثير بقوله: (وكان المهدي مستهتراً بالنساء فيخوض يعقوب معه في ذلك …) (2) .
ويتحدث الطبري والجهشياري وابن الأثير عن مجالس الخمر في قصر المهدي قائلين: (… وكان أصحابه - أصحاب المهدي - عمر بن بزيع والمعلّى مولاه والمفضل ومواليه يشربون عنده بحيث يراهم، فكان يعقوب ينهاه عن ذلك ويعظه) (3) .
ولا أدري أي حديث يمكن أن يدور بين قوم اجتمعوا على مائدة الخمر.
أتراهم كانوا يتكلّمون في هموم المسلمين، أو في الصوم والصلاة، أو في تحريم الخمر التي يتعاطون كؤوسها؟
____________________
(1) تأريخ الطبري ج8 حوادث سنة 166 ص157.
(2) ابن الأثير ج5 حوادث سنة 166 ص251.
(3) الطبري ج8 حوادث سنة 166 ص160، والوزراء والكتّاب ص 159، 160، وابن الأثير ج5 حوادث سنة 166 ص253.
وماذا كان يفعل بشّار وأصحابه (الزنادقة) غير ما يفعله هؤلاء وهم مجتمعون على مائدة شربهم في حضرة (أمير المؤمنين). غير أنّهم لا يملكون موهبة بشّار وأصحابه. ولو ملكوها لنقل لنا المؤرّخون من شعرهم ما لا يختلف عن شعر بشّار ورفاقه.
إذن ما الذي دعا إلى قتل بشّار وهو يخالط المجّان الداعرين من الشعراء ويشاركهم مجونهم ودعارتهم (1) ويقول الشعر الفاحش الداعر مدة ثمانين عاماً فلا يمنع من ذلك إلاّ ما يروى عن نهي المهدي له، وهو كل ما يروى في هذا الشأن، مع أنّ المهدي قد يشاركه فيه أحياناً كما رأينا.
هل تذكّر المهدي زندقة بشّار بعد ثمانين عاماً فقتله بها؟!
ما أحسبني أقبل هذا إلاّ إذا تعرّضت للسياط التي ذهبت بحياة بشّار.
فلألتمس السبب في غير الزندقة، بعد أن رفضتها سبباً ما يزال البعض يتعلّق به لتبرير مقتل بشّار.
____________________
(1) لم أجد في الأغاني على طول ترجمة بشّار ما يشير إلى علاقته بالشعراء المجّان: كوالبة ومطيع وحماد الراوية ويحيى بن زياد، وغيرهم ممّن يذكرهم الشريف المرتضى نقلاً عن الجاحظ. وحين رجعت إلى الجاحظ في حديثه عن الزنادقة في (الحيوان) لم أجد ذكراً لبشّار، بل فيه (وكان بشّار ينكر عليهم) ولا أدري من أي كتب الجاحظ نقل المرتضى ما نقل عن علاقة بشّار بهؤلاء.
ولم يعرض أبو الفرج لعلاقة بشّار بحماد عجرد إلاّ في موضعين: هجا حماد بشّاراً في الأول منهما معيّراً إيّاه بأبيه (الطيان ذي التبان) وذكر في الثاني أنّ بشّاراً هجا حماداً دون إيراد الأبيات التي هجاه به. ولم يكن في هجاء حماد لبشّار عبث ولا مجون، لكنّ أبا الفرج على العكس ينص على عمق بشّار واتجاهه الفكري الجاد حين يقول: (كان بالبصرة ستة من أصحاب الكلام: عمرو بن عبيد، وواصل بن عطاء، وبشّار الأعمى، وصالح بن عبد القدوس، وعبد الكريم بن أبي العوجاء، ورجل من الأزد - قال أبو أحمد يعني جرير بن حزم - فكانوا يجتمعون في منزل الأزدي ويختصمون عنده …).
كان بشّار شاعراً ككل شعراء ذلك العصر، يبحث عن الجوائز والمال، ومع الجوائز والمال، الجاه الذي يسبغه عليه قربه من أُولي الأمر وتقديمهم له على أقرانه. وهو ما يطمع به الشعراء ويحرصون عليه، جاهلية وإسلام. وكان سبيل ذلك كله الخلفاء في الدرجة الأُولى، وطريقهم إليه وزراؤهم وأصحاب النفوذ في قصورهم. وفي بداية الـ 160 للهجرة استطاع يعقوب بن داود أن يتمكّن من المهدي وينفرد بتدبير الأمور. ويبدو أنّ يعقوب قصر في حق بشّار ولم يرع منزلته ولم يثبه على مدحه للخليفة وله أيضاً؛ وهذا ما غاظ بشّاراً وأحفظه من يعقوب.
وكان المهدي قد عزل محمد بن سليمان بن علي العباسي عن البصرة وولّى مكانه صالح بن داود أخا يعقوب، فقال بشّار يهجو صالحاً، ومن بعيد، المهدي نفسه.
هم حملوا فوق المنابر صالحاً |
أخاك فضجّت من أخيك المنابرُ |
ولم يكن في هذا البيت هجاء مباشر واضح للمهدي، وإنّما هجاء لصالح بن داود ولم يستطع يعقوب أخوه أن يدفع المهدي إلى الانتقام من بشّار لبيتٍ قاله في أخيه أو حاول ولم ينجح.
لكن بشّار لم يقف عند هجاء صالح أو يعقوب أخيه، ولم يكتف بهم، بل حمله الغيظ على هجاء المهدي نفسه هذه المرة، فقال فيه:
بني أُميـّة هبّـوا طال نومكـم |
إنّ الخليفة يعقوب بن داودِ |
|
ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا |
خليفة الله بين الزقِّ والعودِ |
وهو في هذين البيتين لا يهجو المهدي فقط بتخلّيه عن أمور المسلمين وانصرافه إلى لهوه ولذّاته بين الزق والعود كما يقول، وإنّما يحرّض المهدي على يعقوب الذي جعل منه الخليفة ويغريه به.
وما أحسب بشّاراً إلاّ قد أراد الاثنين في بيتيه: أن يهجو المهدي، وأن يفسد بينه وبين يعقوب فيكون قد اشتفى منهما معاً.
لكنّه على كل حال قد أثار المهدي في هجائه له، ثم لم يلبث أن قال في المهدي ما لا يحتمله خليفة ولا غير خليفة.
اسمع إليه وهو يتهم المهدي بما لو اتهم به أحداً من سوقة الناس لما تأخّر في قتله إلاّ ريثما يقع عليه عيناه.
خَليفَةٌ يَزني بَعَمّاتِهِ |
يَلعَبُ بِالدَبّوقِ وَالصولَجان |
|
أَبدَلَنا اللَهُ بِهِ غَيرَهُ |
وَدَسَّ مُوسى في حِرِ الخَيزُران |
وأظنّك لا تجهل ما ينتظر بشّاراً بعد هذين البيتين: لقد أخذته السياط حتى قضى تحتها وأُلقيت جثّته في البطيحة.
وإن كنت أشك أن يكون البيتان الأخيران لبشّار وإنّما وضعا على لسانه بتدبير يعقوب. وقد يؤيّد ذلك أنّ الرواية المتداولة تذهب إلى أنّ يعقوب قد أرسل إلى بشّار مَن قتله في الطريق قبل أن يصل إلى المهدي الذي بعث في طلبه، خشية أن يعفو عنه إذا تبيّن براءته من البيتين. بل خشية ما هو أكثر من العفو عن بشّار إذا تبين، مع براءة بشّار منهم، أنّهما قبلا بتحريض ودفع من يعقوب الذي ستتجه إليه السياط بدلاً من بشّار.
هكذا انتهى بشّار، لم تقتله الزندقة ولكن قتله هجاء الخليفة وعمّاته وبنو أُميّة ويعقوب ابن داود.
أتراني بعد في حاجة وقد عرضت السبب في مقتل بشّار وانعدام الصلة بينه وبين ما اتهم به من الزندقة، إلى الرواية التي اعتاد المؤرّخون له أن يختموا بها حديثهم عنه والتي قد يكون من المناسب أن آتي بنصّها عن صاحب الأغاني.
تقول الرواية: (لمّا ضرب المهدي بشّاراً بعث إلى بيته مَن يفتّشه، وكان يتهم بالزندقة فوجد في منزله طومار فيه:
بسم الله الرحمن الرحيم
إنّي أردت هجاء آل سليمان بن علي لبخلهم فذكرت قرابتهم من رسول الله (ص) فأمسكت عنهم إجلالاً له (ص) على أنّي قد قلت فيهم:
دينارُ آلِ سُلَيمانٍ وَدِرهَمُهُم |
كَالبابِلِيَّينِ حُفّا بِالعَفاريتِ |
|
لا يبصران وَلا يُرجى لِقاؤُهُما |
كَما سَمِعتَ بِهاروتٍ وَماروتِ |
فلمّا قرأه المهدي بكى وندم على قتله وقال: لا جزى الله يعقوب بن داود خيراً فإنّه لمّا هجاه لفّق عندي شهوداً على أنّه زنديق فقتلته، ثم ندمت حين لا يغني الندم.
أتراني استطعت أن أنصفك من بعض ما اتهموك به يا أبا معاذ؟
لقد حاولت ولكن بعد أربعة عشر قرن.
وبعد فهؤلاء هم، أُسراً وأفراداً، أشهر الذين قتلوا في الزندقة. ولقد رأينا أن ليس بينهم واحد فقط قُتل فيه، وأنّ الذي قتلهم لم يكن غير السياسة والصراع السياسي، وما يتصل به وما هو قريب منه.
قد يكون بينهم مَن كان زنديقاً حقاً. فأنا لا أتحدث عن زندقتهم أو عدمها، وإن لم تثبت حتى الآن على أحد منهم، ولكنّي أتحدث عن أسباب قتلهم التي لم تكن لها صلة بالزندقة.
لقد كانت الزندقة - كما قلت قبلاً - سلاحاً بيد السلطة، تجرّده حين تشاء على مَن تشاء من خصومها للقضاء عليهم والتخلّص منهم، لا غيرة على الدين ولا احتراماً له. والخلفاء أوّل مَن ازدراه وسخر منه وعبث بأحكامه. ولو كان الأمر بيد سواهم لكان هؤلاء الخلفاء أول مَن يقدّم بتهمة الزندقة وأول المضروبة أعناقهم فيه.
مَن الذي فتح باب الزندقة وجرأ الناس عليها ودفعهم دفعاً إليها، غيرهم وغير الحياة الداعرة الفاسقة البعيدة عن أي دين والتي كانوا يحيونها، حتى أصبحت هي الحياة.
مَن الذي كان يملك المال والجواري والغلمان، ويفتح قصوره للمجّان الداعرين من الشعراء الذين أطلق عليهم اسم الزنادقة، غير الخلفاء؟ ومَن الذي كان يطلب من هؤلاء الشعراء أن يصفوا مجالسهم ومجونهم ودعارتهم، غير الخلفاء؟ فتشيع وتذيع بين الناس، يتناقلون أخبارها ويتنافسون في محاكاتها بقدر ما تتّسع ظروفهم لها.
وماذا تنتظر غير هذا، وقد ملأ الخليفة قصره بالغلمان والجواري من كل الألوان والأجناس والأوصاف، ثم جمع إليهم الشعراء العابثين الماجنين الأذكياء، مع خفّة الروح وسحر الحديث والغزل الفاضح الفاحش في مجالس خمر لا يكون الرقص إلاّ أهون ما يحصل فيها.
وما دام الخلفاء قد سمحوا لأنفسهم بكل ذلك غير متحرجين ولا متكتمين. فلماذا لا يسمح الآخرون من الأمراء والوزراء وأصحاب المال والنفوذ لأنفسهم ما استحله (أمراء المؤمنين) وفعلوه؟ لماذا يمتنعون مما لم يمتنع الخلفاء الذين قامت خلافتهم باسم الدين، وبدعوى القرابة من رسول الله: القاعدة التي يستمدون منها شرعيتهم وبقاءهم واستمرارهم.
أرأيت إلى المهدي الذي يصفه المؤرّخون بأنّه كان غيوراً شديد الغيرة. يدخل فيشاهد إحدى جواريه تغتسل، عارية طبعاً، فيريد أن يصف منظرها ذاك فلا يواتيه إلاّ نصف بيت ثم يحصر، فيطلب من بشّار أن يدخل ويتصوّر منظر جاريته العارية - وربّما هو الذي تولّى وصفه له - ليجيز نصف البيت الذي وقف عنده المهدي.
فإذا كانت هذه حال المهدي الغيور الشديد الغيرة، والدولة العباسية لم يمض على قيامها أكثر من ثلاثين عاماً، فكيف ستكون حال الذين أتوا بعده، وممّن لم يكونوا في مثل غيرته؟!
لقد كان الشعراء (الزنادقة) ندماء الخلفاء، لا تعمر مجالسهم إلاّ بهم ولا يكتمل سرورهم إلاّ بحضورهم. فالحديث عن قتلهم بسبب الزندقة - حتى مع افتراض صحّة التهمة - حديث مَن يريد أن يضلّل قارئه أو يضلّل نفسه أو الاثنين معاً. وحسبك من تأريخ لا يكتبه ولا يقرؤه إلاّ هذا وذاك.
أكان واحد من الشعراء (الزنادقة) يستطيع دخول قصر الخليفة أو يجرؤ على الدنو منه، وألف حاجب وحارس متقلدي سيوفهم يحيطون به ويذودون الناس عنه.
هذا ما يخص الزندقة في وجهها القائم على اللهو والعبث والمجون. أمّا زندقة الفكر البعيدة عن اللهو والعبث والمجون، فهي ليست مقطوعة الصلة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي كان سائداً آنذاك، والذي ساعد على انتشار زندقة اللهو ويسّر سبيلها وسهّل ممارستها.
فهذا الوضع إن كان يدفع أحياناً بفعل معاكس إلى النسك والزهد والعودة إلى الدين والتمسّك به والالتزام بتعاليمه إلى حد الجمود، فأن هناك مَن يشطح به الفكر أحياناً، وبفعل معاكس ناتج عن ذلك الوضع نفسه، إلى الكفر بالدين والخروج عليه وتحميله تبعة ما يعاني منه الناس.
مَن يستطيع أن ينكر أثر العامل الاقتصادي وما يمكن أن يؤدّي إليه من جموح فكري لدى البعض، وهو يرى هذا البذخ الأسطوري فيما لا غناء فيه ولا نفع، ويرى ما يقابله من فقر وبؤس، كان من الممكن أن يخفّف منه ومن الإحساس به، إنفاق جزء ممّا ينفق هناك على العبث والمجون وموائد الخمر، وما لا يريد الإنسان ذكره.
لقد استأثر أمير المؤمنين وأُسرته وبطانته من أُمراء ووزراء ومن جوار ومحظيات بكل مصادر الثروة - على كثرتها - حتى ضاقت على الناس معيشتهم، فهم قد يجدون وقد لا يجدون ما يديمون به حياتهم.
هذا الفضل بن الربيع يبني قصره في بغداد فيهب له الرشيد خمسة وثلاثين ألف ألف درهم (معونة) على بناء القصر الذي لا بد أنّه كلّف أكثر من ذلك المبلغ بكثير.
وتستطيع أن تقدّر المبلغ قدره إذا علمت أنّ كل ما يحمل إلى بيت المال من مال ومتاع من جميع كور دجلة وحلوان وكرمان وسجستان لا يتجاوز أربعة وثلاثين ألف ألف وأربعمائة ألف درهم، وأنّ أرزاق الكتاب منذ عهد المنصور وحتى أيام المأمون لم تزد على 300 ثلاثمائة درهم للرؤساء منهم.
والمأمون: الخليفة العاقل الحكيم كما يوصف دائماً، يتزوّج من بوران بنت الحسن بن سهل، وهي واحدة من كثيرات، فيكلّف هذا الزواج مائة واثني عشر ألف ألف درهم (مائة واثني عشر مليون درهم) غير ما وزع من الذهب والدر والجواهر، وغير ما منح بالمناسبة السعيدة من الضياع والجواري على الحاضرين من الأُمراء والقادة، وغيرهم من الفقراء والمحرومين!! وغير حصير الذهب الذي فرش لبوران تمشي عليه ليلة زفافها.
ومثل ذاك أو أكثر منه كلّف ختان المعتز بن المتوكل.
فإذا وصلنا إلى المستعين وأمّه، نكون قد وصلنا إلى الجنون الذي لا جنون بعده.
وسأدع الأبشيهي يحدثنا عن ذلك في المستطرف (1) :
(وقال أحمد بن حمدون النديم: عملت أم المستعين - الخليفة العباسي - بساطاً على كل حيوان من جميع الأجناس وصورة كل طائر من ذهب، وأعينهم يواقيت وجواهر، أنفقت عليه مائة ألف ألف دينار وثلاثين ألف دينار، وسألته أن يقف عليه وينظر إليه، فكسل ذلك اليوم عن رؤيته. قال أحمد بن حمدون: فقال لي ولاترجة الهاشمي: اذهبا فانظرا إليه، وكان معنا الحاجب، فمضينا ورأيناه، فو الله ما رأينا في الدنيا شيئاً أحسن منه، ولا شيئاً حسناً إلاّ قد عمل فيه، فمددت أنا يدي إلى غزال من ذهب عيناه ياقوتتان، فوضعته في كمّي، ثم جئناه فوصفنا له حسن ما رأيناه، فقال أترجة: يا أمير المؤمنين: إنّه قد سرق منه شيئاً، وغمزه على كمّي، فأريته الغزال، فقال: بحياتي عليكما أرجعا، فخذا ما أحببتما فمضينا، فملأنا أكمامنا وأقبيتنا وأقبلنا نمشي كالحبالى، فلما رآنا ضحك، فقال بقية الجلساء: ونحن فما ذنبنا يا أمير المؤمنين؟ فقال: قوموا، فخذوا ما شئتم، ثم قام فوقف على الطريق ينظر كيف يحملون ويضحك. ونظر يزيد المهلبي سطلاً من ذهب مملوءً مسكاً فأخذه بيده وخرج، فقال له المستعين: إلى أين؟ فقال: إلى الحمام يا أمير المؤمنين، فضحك من قوله. وأمر الفرّاشين والخدم أن ينتهبوا الباقي، فانتهبوه، فوجهت إليه أُمّه تقول: سرّ الله أمير المؤمنين لقد كنت أحب أن يراه قبل أن يفرّقه فإنّني أنفقت عليه مائة ألف ألف وثلاثين ألف دينار، فقال: يحمل إليها مثل ذلك حتى تعيد مثله، ففعلت، ومضى حتى رآه، وفعل به كفعله بالأول).
____________________
(1) المستطرف في كل فنٍّ مستظرف لشهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهي، نشر دار الكتب العلمية بيروت ط1993 شرح الدكتور مفيد محمد قميحة ص176.
وسأكمل لك ما لم يقله الأبشيهي:
فإذا علمنا أنّ الدينار يساوي اثني عشر درهماً يكون مجموع ما أنفق على هاتين السجادتين 000 400.720 2 (مليارين وأربعمائة مليون وسبعمائة وعشرين ألف درهم)
أرأيت إلى هذا المبلغ الزهيد!! ما قيمته إذا استطاع أن يدخل السرور، ولو لدقائق معدودات، إلى قلب أمير المؤمنين الذي ما أظنه إلاّ كان مسروراً دائماً، وهو وأُمّه يعبثان بهذه المليارات التي جمعت من جهد مَن اضطروا أن يأكلوا القطط، وينتظروا لحوم الموتى من أهلهم ومن غير أهلهم، ليديموا حياتهم؟!!
ما قيمة مليارين وأربعمائة مليون وسبعمائة وعشرين ألف درهم في سجّادتين يداس عليهما بالأرجل، ثم ينتهبهما الحاشية والغلمان إذا كان في ذلك ما يسعد أمير المؤمنين؟! وهل هناك أهم عند المسلمين وأعظم خطراً من سعادته وسعادة والدته؟!!
ولقد سبق أن أخبرتك أنّ أرزاق الكتّاب والعمّال كانت إلى زمن المأمون ثلاثمائة درهم للرؤساء منهم (1) فهذا يعني أنّ ثمانية ملايين وألفين وأربعمائة من رؤساء الكتّاب والعمّال وما يعيلون من أُسر يتضاعف معها العدد، لا يتجاوز ما يدفع لمعيشتهم ثمن سجّادتين، في زمن الخلافة الرشيدة التقيّة المؤمنة التي ما تزال تجد حتى اليوم في أوساط المسلمين، مَن يدافع عنها بل مَن يدعو للعودة إليها.
____________________
(1) الوزراء والكتّاب للجهشياري، تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الابياري وعبد الحفيظ شلبي، ط أُولى مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة 1938 ص126.
هكذا كان واقع الحياة الإسلامية التي يريد المزوّرون أن يصوّروها جنّة يحار المسلم بم يبدأ يومه من طيباتها.
لقد كان هناك تفاوت كبير، بل غير معقول بين طبقة صغيرة، على رأسها أمير المؤمنين، تملك كل شيء، وطبقات كبيرة حرمت كل شيء.
وقد انعكس هذا التفاوت في شطح فكري بلغ حد الكفر، يمثّله بعض ما وصل إلينا من شعر ذلك العهد.
ولأنقل لك بعض ما حضرني منه، وأنا أتحدث عن العامل الاقتصادي وعلاقته بزندقة الفقر:
فهذا شاعر يرى مملكة آل طاهر بن الحسين من العبيد وكثرة عددهم وهو لا يملك إلاّ واحداً، فيموت هذا الواحد الذي كان يعينه في أمور حياته فلا يتماسك أن يقول مخاطباً الله:
تركت عبيد بني طاهرٍ |
وقد ملؤوا الأرض عرضاً وطولا |
|
وأقبلت تسعى إلى واحدي |
ضراراً كأنّي قتلـت الرسـولا |
|
فسوف أدين بترك الصلاة |
وأصطبح الخمر صرفاً شمـولا |
وهذا الخبّاز البلدي يقول كما يذكر الثعالبي في اليتيمة:
يـا قاسم الرزق لم خانتني القسمُ |
ما أنت متّهم قل لي مَـن اتهـمُ |
|
إن كان نجمي نحساً أنت خالقـه |
فأنت في الحالتين الخصم والحكمُ |
وهو يمثّل إلحاداً أو خروجاً على الدين في الأقل بسبب الفقر.
وهذا آخر اسمه أحمد بن محمد المتيّم: يقول هو الآخر وقد لامته زوجته على تركه الصلاة، فأجابها يشرح لها أسباب ذلك. وأظنّها كانت تلح عليه وتبرمه بإلحاحها ليعود إلى صلاته. ولذا نراه لا يكتفي بما شرح، ولكنّه مع الشرح، يطلقها ليستريح من إلحاحها ومضايقتها له. استمع إليه وهـو يقول:
تلوم على ترك الصلاة حليلتي |
فقلت اعزبي عن ناظري أنتِ طالقُ |
|
فـو الله لا صلّيـت لله مفلسـاً |
يصلّي له الشيخ الجليـل وفائقُ |
|
لماذا أُصلّي أين مالي ومنزلي |
وأين خيولي والحلى والمناطقُ |
|
أُصلّي ولا فتر من الأرض يحتوي |
عليه يمينـي إنّنـي لمنافقُ |
|
بلى إن عليّ الله وسّـع لم أزل |
أُصلّي له ما لاح في الجو بارقُ |
وأنا أرفض طبعاً مذهب الشاعر في ربط إيمانه بالله وعبادته له بالمال والخيل والحلي. وإنّما أردت فقط أن أنبّه إلى هذا التفاوت الذي تجاوز الحد المعقول وغير المعقول في الغنى والفقر، وما قد يؤدّي إليه لدى البعض من شطحات تصل حد الزندقة، إذا لم يكن الفكر محصناً بما يحفظ إيمانه.
ولا يقل العامل السياسي أثراً في الشعور بالأزمة المستحكمة التي كان يعاني منها الفرد والتي تمهّد الطريق إلى نوع من الزندقة، ليست منها في شيء زندقة اللهو والعبث والمجون.
لقد كان النظام السياسي من الفساد بما لا يوصف في دولة الفرد الذي هو أمير المؤمنين.
ولكن ما أريد أن أقف عنده وأشير إليه هنا، هو هذا النظام المتخلف الذي اسمه (ولاية العهد) وهو أُسلوب في الحكم يتّجه أول ما يتّجه إلى مصادرة حرية المسلمين، فيفرض عليهم حاكماً أو حكّاماً أطفالاً أو بلداء، لا يحسنون الحكم ولا يحلمون به، ولم يعانوا ولم يدفعوا ثمناً للوصول إليه لولا أن يفرضهم مَن كان بيده الحكم على الناس، سالكاً في ذلك مختلف الوسائل.
ولقد خلق هذا العهد وولايته وخرقه ونقضه من المشاكل، وكلّف المسلمين من الدماء والدمار ما هو معروف للجميع، ولكنّه خلق ولا شك لدى المسلمين أو بعضهم على الأقل شعوراً بالمرارة والحقد والاستياء أن يساسوا بهذا الشكل المزري، وكأنّهم أنعام تساق من مالك إلى مالك يبيعهم أو يتنازل عنهم السابق للاحق.
وهكذا زرع الخلفاء العباسيون وقبلهم الأمويون بذور الزندقة، ثم رعوها ونموها وغذوها ولم يقطعوا منها إلاّ ما آذاهم من شوكها.
إنّها السياسة كما قلت. ولو لم تكن السياسة وراء القتل، ولو لم تكن السلطة هي التي تفرضه، فلمَ ترد توبة الزنديق - على اتساع هذا المفهوم - ويستتاب المرتد وتقبل توبته. وما أظن الزندقة في كل وجوهها تبلغ أو تتجاوز حد الارتداد.
ولو لم تكن السياسة وراء القتل، فلمَ تقبل توبة البعض من هؤلاء الزنادقة وترفض توبة الآخرين وتُضرب أعناقهم؟!
أكانت الزندقة تختلف من شخص لآخر، ومن جماعة لأُخرى؟!
أمّا أنا فأجيب بنعم، ذلك أنّ الزندقة التي تحاربها السلطة، هي زندقة الفكر والسياسة، حين تخرج وتتحرك، أو حين تدخل الصراع السياسي. هذه الزندقة هي التي تمثّل الخطر الحقيقي على السلطة ورؤوسها، من خلفاء فما دونهم أو فوقهم أحياناً. وهي أخطر من الردة التي لا تتجاوز علاقة صاحبها بالله، وهم غير معنيّين به إلاّ كسيادة وحكم وسلطان؛ ولذا جاءت عقوبة الزندقة هنا أقسى من عقوبة الردّة.
أمّا الزندقة التي تشغل الناس عن السلطة وتلهيهم وتصرفهم عن التفكير في واقعها وواقعهم، فليست من الزندقة التي تحاربها السلطة، إن لم تشجّع عليها ما دامت قائمة بمهمّتها في إلهاء الناس، وإبعادهم عن التفكير في هذه المأساة التي يحيونها وفي أسبابها (1) .
____________________
(1) وكم أثار استغرابي قول الجاحظ في كتابه (الرد على النصارى): (ألا ترى أنّ أكثر مَن قتل في الزندقة ممّن كان ينتحل الإسلام ويظهره، هم الذين آباؤهم وأُمّهاتهم نصارى..).
وعدت إلى كل الذين ذكرتهم ممّن قتلوا في الزندقة، فلم أجد واحداً فقط كان نصرانياً من جهة أبيه أو أُمّه.
والمشكلة مع الجاحظ، أنّك لا تستطيع أن تعتمد عليه في قضايا التأريخ الإسلامي؛ فهو يكتب الشيء ونقيضه، ربّما ليدلل بذاك، على سعة اطلاعه وقدرته على الإقناع، وقوّته في المناظرة والجدل ورد الخصوم. رسائل الجاحظ - تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون - نشر مكتبة الخانجي - المجلد الثالث ص315.
القسـم الثانـي:
الشعوبيّة
أوّل ما يواجهك في موضوع الشعوبية هي هذه النسبة المخالفة لما سار عليه النحاة، وهم يتعرّضون لبحث النسب في كتب النحو. لماذا الشعوبية وليس الشعبية بالمفرد، والنسبة لا تكون للجمع (الشعوب) إلاّ في حالات ينص عليها النحاة على وجه الحصر، وليس من بينها هذه الحالة.
هل كانت هذه النسبة مقصودة للدلالة على معنى، لا يمكن أن تدل عليه النسبة إلى المفرد، فتراجع النحو لحساب السياسة وخضع لأحكامها.
هذا ما أظن، إذ إنّ المقارنة والمفاضلة لم تكن في الأصل بين العرب وبين شعب بذاته، وإنّما كانت بين العرب وبين غيرهم من أُمم وشعوب كثيرة دانت لهم؛ وهذا ما لا يمكن التعبير عنه بلفظ المفرد (شعب) والنسبة إليه (شعبي) وإلاّ أخطأنا المراد.
ثم إنّ اصطلاح الشعوبية بما يتضمّنه من جمع للشعوب الأخرى، وتسوية لها في صف واحد مقابل العرب، سيعزّز ارتباط هذه الشعوب ببعضها ويوحّدها في مواجهة مَن يعتبرونه عدوّاً لهم جميعاً، ويشعرهم بالقوّة إزاءه ويدعم دعواهم في المطالبة بالتسوية معه، أو فيما يتجاوز التسوية إلى تفضيلهم على العرب. ولن يقف إلى صف العرب عند ذاك شعب من هذه الشعوب، في موضوع قريب من السياسة بعيد عن الدين الذي يجعل من المسلمين عرباً وغير عرب أُمّة واحدة.
هذا من جانب (الشعوب) الأُخرى، أمّا من جانب العرب فالأمر على العكس، إذ ربما أراد المتعصّبون منهم ألاّ يقصدوا المفاضلة بين العرب وبين شعب من هذه الشعوب فقط وتفضيل العرب عليهم. وإنّما أرادوا المقارنة والمفاضلة بين العرب وبين كل تلك الشعوب وتفضيل العرب عليها، فهي تتساوى كلها بالنسبة للعرب وإن اختلفت فيما بينها علوّاً وانحطاطاً.
يضاف إلى كل ذلك أنّ النسبة للمفرد (شعبي) لا تخلو من غموض وإبهام. فهل يقصد باللفظ ما يقابل الرسمي أو الحكومي؟ هل يقصد به شعب معيّن ومَن هو، وأي شعب يمكن أن يكون مصداقاً له؟ الفارسي أو الرومي أو الهندي … الخ.
وهكذا سارت هذه التسمية التي يبدو أنّ المؤلّفين العرب ارتضوها وفضّلوها، كل من رؤية خاصة به، للتعبير عن حركة سياسية ثقافية عرقية، ساهمت إلى حد كبير في إضعاف الروابط بين أبناء الأُمّة الإسلامية الواحدة وأوشكت أن تمزّقها.
ولنترك النحو وأقيسته ورجاله إلى التأريخ؛ لنرى كيف ظهرت هذه الحركة وماذا كانت تعني عند ظهورها، ثم كيف تطوّرت بعد ذاك؟ وما هي العوامل التي ساعدت على ظهورها، ثم على تطوّرها حتى هددت في وقتٍ ما وحدة المسلمين، وكادت أن تقضي عليها بما أشعلت من حروب وأزهقت من أرواح وأسالت من دماء وأورثت من كره وحقد وعداء استمر طويلاً.
حين بعث الله محمّداً بالإسلام بعثه للناس جميعاً وكان العرب (مهاجرون وأنصار) طبعاً أول مَن استجاب للدعوة التي بدأت بهم وقامت بينهم. وهم الذين حملوا الإسلام وتحمّلوا وجاهدوا وقاتلوا لإعلاء كلمته ضد العرب من أعدائه أوّلاً، ثم ضد غير العرب من الأُمم الأُخرى بعد دخول العرب أو غالبيتهم فيه.
ولم يكن في أيام الرسالة الأُولى مسلمون من غير العرب إلاّ أفراداً لا نكاد نعرف منهم أكثر من ثلاثة هم: سلمان الفارسي، وبلال الحبشي، وصهيب الرومي الذي لم يكن رغم لقبه رومياً، بل عربياً من النمر بن قاسط من ربيعة أصابه سباء في الجاهلية، وقيل نشأ في الروم فغلب عليه اسمهم لطول مكثه فيهم، وهو أحد السابقين إلى الإسلام والذين أُوذوا وعذبوا فيه.
بقي من الثلاثة اثنان هما سلمان الفارسي وبلال الحبشي، وقد كانا من السابقين إلى الإسلام، أبليا فيه وجاهدا في سبيله.
أمّا سلمان فكان هو صاحب فكرة الخندق يوم الأحزاب، وبرأيه وحسن تدبيره تجنّب المسلمون ما كان ممكناً أن يحصل لهم لولا الخندق الذي حماهم من كيد المشركين وكسر شوكتهم، وردّهم دون أن يظفروا بشيء غير قتل فارسهم عمرو بن عبد ود.
وأمّا بلال مؤذّن الرسول فقد تحمّل ما لا يتحمّله إلاّ القلّة من الذين رزقهم الله القوّة والصبر على تحمّل الأذى والاستهانة به.
وما أظن الذين لم أذكرهم من المسلمين غير العرب إذا كان هناك آخرون لم أذكرهم يتجاوزون في ذلك العهد عدد مَن ذكرتهم منهم.
وما أظن هؤلاء بمجموعهم، وهم لا يرجعون لجنس واحد، يستطيعون أن يستفزّوا العرب أو يثيروا لديهم شعوراً بالغيرة أو العداء، وهم كما قلت قد دخلوا الإسلام عن عقيدة راسخة وإيمان عميق، استهانوا معهما بكل ألوان التضحية وضروب العذاب التي تعرّضوا لها أيام ضعف الإسلام، وعدم قدرة المسلمين على حمايتهم من جبابرة العرب في ذلك العهد.
وتوفّي النبي محمد (ص) وتبعه بعد سنتين أبو بكر ولم يجد شيء ذو بال بالنسبة لهؤلاء، ولم يزدد عددهم كثيراً عمّا كان عليه.
وجاء عهد عمر وجاءت معه الفتوح، ومع الفتوح المال والغنائم والأسرى والسبي.
وكثر عدد هؤلاء الأجانب الذين كانوا يعتبرون من جملة الغنائم. وكثر من جهة أُخرى عدد الداخلين في الإسلام من غير هؤلاء بعد الذي رأوا أو سمعوا عن سماحته وعدالته ومساواته بين المسلمين، وعليهم جميعاً أطلق اسم: (الموالي).
وكان المسلمون الأوائل الذين ذاقوا مرارة الذل والقهر، والذين يعيشون قيم الإسلام كما عرفوها في زمن صاحب الرسالة، يحسنون التعامل مع هؤلاء الموالي الذين لم يشعروا بوطأة الهزيمة قدر شعورهم بسعادة الدخول في الدين الجديد.
لكن هذا لا يعني أنّ العرب المسلمين جميعاً كانوا يسيرون على نفس الأسلوب في تعاملهم مع الموالي، وتنفيذ ما يأمر به الإسلام من الرفق بهم والعطف عليهم وإعطائهم حقوقهم.
فإلى جانب أولئك العرب المسلمين، كان هناك نمط ثان من الذين دخلوا الإسلام متأخّرين كرهاً أو طمعاً، ولم يستطيعوا أن يتمثّلوه ولا أن يستبدلوه بما نشؤوا عليه من عادات وتقاليد في جاهليتهم، وهي ليست بعيدة.
فهؤلاء لم يسيروا مع مواليهم سيرة المسلمين الآخرين، ولم يلتزموا بما فرضه الإسلام لهم من حقوق، ولم تخل نظرتهم إليهم وتعاملهم معهم من استعلاء وترفّع يمثلان الحالة السائدة بين منتصر ومهزوم، أو بالأحرى بين مالك ومملوك.
ولا بد أن يكون بين الموالي مع مرور الوقت، مَن صدمته هذه المعاملة ومَن كان يرفضها ويتمرّد في داخله عليها، وهو يستعيد ذكرياته عن ماضيه قبل أن يصبح رقّاً ينقله سيّده معه حيث سار، ويبيعه أو يتنازل عنه كلما شاء لمَن شاء.
لكن ذلك لم يكن القاعدة، وكان الأمل مبسوطاً أمام الموالي في انتهاء حالة قد تكون شاذّة، خصوصاً وأنّ الإسلام كان حتى ذلك العهد قوياً بأصحابه الذين حملوه فتياً، ووجودهم يخفّف من شعور الموالي بالضيق ويمنحهم الأمل بإن يتبدّل وضعهم نحو الأفضل.
ومضى عمر حميداً مشكوراً لم يملك ولم يخزن، ولم يضعف فيما تحمّل من أُمور الإسلام والمسلمين عرباً وموالي.
وجاء عثمان وجاء معه بنو أُميّة. ولم يكن هؤلاء بحق موضع ثقة المسلمين سيّما الأوائل الذين عاصروا الإسلام أيام ضعفه. وهم لا ينسون أنّ بني أمية كانوا من أشد المحاربين له المؤلّبين عليه. لم ينسوا أبا سفيان، ولم ينسوا الحكم بن أبي العاص، ولم ينسوا عقبة بن أبي معيط، ولا أخوتهم من بني عبد شمس: عتبة وشيبة والوليد. ولم يسلم الأمويون باستثناء بضعة نفر إلاّ بعد أن أسلم الناس وقوي الإسلام وأخفقت كل وسائلهم في محاربته وصدّه وصد الناس عنه، وبعدما رأوا أنّ بقاءهم على الامتناع عن الدخول فيه سيضعفهم ويحول بينهم وبين ما يطمحون إليه من سلطان، سيسبقهم إليه مَن سبقهم إلى الإسلام , وازدادت الفتوح وازداد العرب ثراءً وازداد عدد الرقيق من البلاد المفتوحة.
ولم يكن الأمويون الذين غلبوا على عثمان واستأثروا بالسلطة، مع نزعة قبلية متعالية، يحسنون التعامل مع العرب المسلمين أنفسهم، ويشعرون بالتفوّق والفضل عليهم، فما بالك بغير العرب من هؤلاء الموالي الذين جلبتهم الفتوح قهراً، أو أسلموا قبل أن تجلبهم الفتوح قهراً.
وهكذا بدأت تسوء أحوال هؤلاء الموالي، ومع ذاك فلم يبد منهم حتى ذلك الوقت ما يشير أو يعبّر عن موقف خاص بهم. فما يزال هناك صحابة أجلاّء يهربون بهمومهم إليهم، وإسلام يلوذون به ويتفيّؤون ظلاله، وأمل يتسع لهم كلما ضاق بهم واقعهم أو ضاقوا به. ولم ينقل عن واحد منهم قول أو فعل طعن فيه بالعرب أو ذمّ حاضراً أو حنّ إلى ماضٍ، أو حاول استبدال دين بدين ممّن سمّوا فيما بعد بالشعوبيين.
وقامت الثورة على عثمان ولكنّها لم تنته بمقتله. قام بها عرب من قبائل عربية:
الذين حرّضوا على عثمان وأيّدوا الثورة عرب.
والذين ساروا من أمصارهم قاصدين المدينة عرب.
والذين قادوا الثورة عرب.
والذين حاصروا عثمان وقتلوه عرب.
ماذا كان: طلحة، والزبير، وأُم المؤمنين عائشة، وعبد الرحمان بن عوف؟
ماذا كان: الأشتر، وحكيم بن جبيلة، وعبد الرحمان بن عديس؟
ماذا كان: محمد بن أبي بكر، ومحمد بن أبي حذيفة، وعمار بن ياسر؟
والجماهير التي خرجت من الكوفة والبصرة ومصر إلى المدينة تحمل غضبها ومطالبها، هل كانت جماهير الشعوبيين يريدون الكيد للإسلام والثأر من العرب وإعادة مجد فارس؟
هل كان بين كل الذين ساهموا في الثورة على عثمان، ومن خلاله، الثورة على تسلّط الأمويين وتحكّمهم، ابتداءً وانتهاءً، جماهير وقادة، مَن لم يكن مسلماً عربياً من قبيلة عربية معروفة؟
ويبقى هذا اليهودي القادم من صنعاء، على رغم كل ما ذكرناه عن الثورة وشخصياتها، دعاة وقادة ومساهمين ومنفّذين، وعلى رغمه هو، قائداً ومحرّكاً لها ومدبّراً لأمرها، والعقل المفكّر والمخطّط والمنفّذ فيها؛ لأنّ عدداً من الذين يقرؤون التأريخ معكوساً وبعين واحدة، يريدون ذلك ولا يرضيهم إلاّ ذلك، ولو جمعت لهم كل الذين ساهموا في الثورة على عثمان وأقسموا أنّهم لا يعرفون ابن سبأ، أو ابن السوداء هذا ولم يسمعوا به؛ لأنّه غير موجود أصلاً، لكذّبوهم وسخروا منهم واتهموهم بالكيد للعرب والإسلام، ولأصرّوا على أنّ ابن سبأ هذا أو ابن السوداء هو القائد لهم، وأنّهم كلهم لم يكونوا إلاّ منفّذين لخطة خبيثة جهلوها ولم يعرفوا عنها شيئاً، وأنّهم كلهم كانوا ضحية خبثه وجهلهم.
أيمكن أن ألغي عقول كل هؤلاء العرب المسلمين، وفيهم أصحاب الدين والسابقة والفضل والشرف، وألغي عقلي قبلهم، فأقبل أن أجعل منهم مجرّد أتباع مسحورين مخدّرين لا عقل لهم ولا فكر، يسوقهم واحد من اليهود لم يسلم ولم يترك صنعاء إلاّ قريباً؟
أتراهم سيقبلون مني هذا؟! أُقسم أن لو تقدّم بي العمر أو تأخّر بهم أو ببعضهم لجرّوني أمام القضاء بأكثر من تهمة، ربّما أهونها اتهامهم في عقولهم.
كيف استطاع هذا اليهودي الذي لم يسلم، كما يقولون إلاّ قريباً قبل سنتين أو ثلاث، أن يكسب كل هذا التأثير والنفوذ وكل هذه العلاقات والثقة بين ملايين المسلمين من المدينة والكوفة والبصرة ومصر. فيكفي أن يأمرها فتطيع ويوجّهها فتمضي ويطلب منها أن تثور وتقتل فتثور وتقتل. لا تسأل ولا تنتظر ولا تراجع. ولو طلب الله منهم ذلك لما نفّذوه بنفس الهمّة والنشاط الذي نفّذوا به أوامر اليهودي ابن السوداء.
لقد صور هؤلاء (المؤرّخون) العرب المسلمين، مجموعة من الأغبياء أو حتى دون هذا الوصف. لا عقل لهم يرجعون إليه ولا فكر يميّزون به ما هو خطأ ممّا هو صواب. ينقادون لكل أحد، يعرفونه أو لا يعرفونه، مسلم أو غير مسلم، عربي أو مولى. وما أظن الشعوبية تستطيع أن تنزل بالعرب وتحط من قدرهم وتنال منهم، أكثر ممّا نزل وحط ونال الذين يدّعون محاربة الشعوبية: قدماء ومحدثين.
وكانت هذه الثورة - إذا تركنا حروب ما يسمّى بالردّة - أوّل ثورة عربية إسلامية دفع إليها تسلّط الأمويين وتعسّفهم واستئثارهم، وانتهت بمقتل الخليفة الذي لم يرد أو لم يستطع أن يكف أُسرته ويضرب على أيديهم، ويرضي المسلمين ويشعرهم بالعدل والمساواة كما عرفوها من قبل.
ولم أرد أن أطيل الحديث عن هذه الثورة ولا الدخول في تفاصيلها، وإنّما أردت فقط بيان هويتها العربية الإسلامية، وبعدها عن الشعوبية التي يحلو للبعض أن يصفوها بها أو يجعلوها من صنعها.
وجاء المسلمون بعليٍّ خليفة، ودامت خلافته خمس سنوات، مرّت كلها في حروب متصلة أشعلها عرب مسلمون، لا موال ولا شعوبيون حتى انتهت باغتياله عام 40.
وباستشهاد علي انتهى عهد الراشدين وعهد الأُسر المختلفة من قريش؛ ليقوم حكم الأُسرة الواحدة الذي يختلف في قيمه وأساليبه وطريقة تعامله مع الناس عمّا سبقه.
ذلك هو الحكم الأموي الذي بدأ بمعاوية وانتهى بمروان بن محمد عام 132.
ولا أريد الحديث عن بني أُميّة في الجاهلية، فهو أمر معروف وليس من شأننا هنا، ولا الحديث عنهم في الإسلام، فهو أمر معروف أيضاً وقد تعرّضت له عند الحديث عن الثورة على عثمان وعلاقتهم بها.
ولكنّي أريد الحديث عن سياسة الأمويين - وقد صاروا حكّاماً - بقدر ما تتصل هذه السياسة بموضوعنا عن الشعوبية.
عن هذه الصلة بين الحكم الأموي وبين الشعوبية إذن سأتحدث.
وهذا يقتضيني أن أتناول سياستهم مع المسلمين عرباً وموالي لأخلص من بعد، إلى موضوع الشعوبية في العصر الأموي.
لقد قامت سياسة الأمويين على البطش والشدّة في التعامل مع المسلمين والقسوة عليهم وعدم الرفق بهم.
فهذا زياد بن أبيه يقوم في البصرة خطيباً فيعلن أنّه سيأخذ الحاضر بالغائب والبريء بالمذنب.
وهذا مسلم بن عقبة المري يبلغ من قتلهم يوم الحَرّة من أهل المدينة في المعركة، أو بعد انتصاره ودخوله المدينة، سبعمائة من وجوه الناس من المهاجرين والأنصار، وعشرة آلاف من غيرهم. ثم لا يكتفي حتى يبيح المدينة لجيشه ثلاثة أيام يفعل فيها ما يشاء.
وهذا الحجّاج بن يوسف يخطب في الكوفة فيهدّد بأنّه يرى رؤوساً قد حان قطافها وأنّه لصاحبها.
وهذا عبد الملك بن مروان يقول مخاطباً أهل مكّة: (.. فمَن قال برأسه كذا قلنا له بسيفنا كذا).
والى جانب هذه الشدّة في معاملة عموم العرب والمسلمين، كان هناك جانب آخر لا يقل خطورة عنه، لجأ إليه الأمويون ومارسوه طوال أيام حكمهم لتثبيت أركانه، وتفتيت حركات المعارضة ضده. هذا الجانب يتمثل فيما اتجه إليه الأمويون من إحياء العصبية القبلية بعد أن ضعف دورها وكاد أن يتلاشى في الحياة الإسلامية.
فمع بداية الحكم الأموي بدأت تبرز وتقوى ظاهرة طالما حاربها الإسلام، وحاول أن يحد من تأثيرها في حياة المسلمين إذ لم يكن ممكناً القضاء عليها تماماً. تلك هي العصبية القبلية التي كانت تمثّل خطراً داخلياً في الحياة الإسلامية، وفيما بين المسلمين الذين كانوا من قبائل مختلفة، لم تخلُ جاهليتها من معارك وحروب وفخر وهجاء.
وقد نجح الإسلام إلى حد كبير أن يحاصر هذه الظاهرة ويخفّف من آثارها ويستبدل بها أُخوّة الإسلام الذي لا تفاضل فيه إلاّ بالتقوى.
لكن ذلك لم يكن ليريح الأمويين الذين يعرفون أنّ المسلمين، خصوصاً أصحاب الفضل والسابقة منهم، لا يرونهم رضا لهم ولا أهلاً لحكمهم. ما كان الأمويون ليجهلوا شعور المسلمين نحوهم وهو خطر دائم عليهم؛ ولذلك فما إن استتب لهم الأمر حتى فكّروا فيما يدفعون به الخطر عنهم، ولم يكن أمامهم أمضى من العصبية القبلية يشعلونها بين المسلمين، وهم بعد قريبو عهد بالجاهلية، فيشغلونهم بأنفسهم ويبعدونهم عن التفكير بهم وبالحكم.
وبدأت جاهلية جديدة: يمن وربيعة ومضر لا تقدّم هذه إلا لتؤخّر تلك. وبدأت المنافسة وبدأت الحروب، فبين كلب وقيس حرب، وبين قيس وتغلب حرب، وبين تميم والأزد حرب، كل قبيلة مشغولة بحربها مع الأخرى.
ومع الحرب بين القبائل وبسببه، بدأت الحرب بين الشعراء، الذين كان كل منهم ينتمي لقبيلة، فيمدح ويفخر ويهجو ما اقتضت مصلحة قبيلته ذلك، ولكنّهم كلهم - مع بعض الاستثناءات التي لا تلغي القاعدة - يمدحون الأمويين الذين يجزلون لهم العطاء بقدر ما يبلغ الشاعر من رضاهم.
وتراجع أصحاب الفقه أمام أصحاب الشعر، وأصحاب الدين أمام أصحاب اللهو، ولم يعد الفقراء وأصحاب الحاجات من المسلمين يجدون مَن يسأل عنهم ويحفل بأمرهم.
وأموال المسلمين تنفق في غير مصارفها الشرعية يشترى بها الرجال واللهو. وحلّت دمشق محل مكّة والمدينة والكوفة والبصرة، واستأثرت بالرعاية دونها.
وولاية العهد التي قد تسند إلى أربعة متتابعين بعد الخليفة، سدّت أمام المسلمين أيّ منفذ أو أمل بانفراج قريب للمحنة التي يعيشونها.
ثم هناك علي بن أبي طالب الذي لا يستطيع خيار المسلمين، لا الشيعة وحدهم، أن يسمعوا على المنابر لعنه وسبّه ممّن لا يمكن أن يقاس به ديناً وسابقة فضل.
هذا هو الوضع كما تؤكّده الوقائع، قد يختلف مع هذا الخليفة عنه مع ذاك، ولكنّنا نتحدث عن الحكم الأموي الذي امتد أكثر من تسعين عاماً، لا عن هذا الخليفة أو ذاك من خلفاء الأمويين.
وأظننا لا نستغرب في مثل هذا الوضع أن تقوم ثورات وثوّار، أصحاب دين انتصاراً لدينهم وغضباً له، أو أصحاب دنيا طلباً للحكم والسلطة باسم الدين وتحت رايته.
ثار هؤلاء وتبعهم الناس وثاروا معهم وقاتلوا وقتلوا في صفوفهم. لم يُجبروا على ذاك ولم يكرهوا، ولم يدفع لهم ثمن للانضمام إليهم والقتال معهم، إلاّ كرههم للحكم الأموي وبرمهم به، وعدم صبرهم على ظلمه ويأسهم من صلاحه.
ثار هؤلاء وكلهم عرب من قبائل عربية شهيرة وأُسر عربية أشهر.
ثاروا طوائف وفرق، وثاروا أفراداً انضم إليهم والتحق بهم هؤلاء المظلومون من العرب المسلمين.
هل كانوا يثورون لو لم يظلم الحكم ويتعسّف ويجور؟
وهل كان سيثور معهم أحد وينضم إليهم أحد، لو لم يكن الحكم فاسداً قد ملّه الناس وملّوا ظلمه وتعسّفه وجوره؟
ثار الخوارج ابتداءً من فروة بن نوفل الأشجعي وحوثرة بن وداع، حتى نافع وقطري وشبيب.
وثار الشيعة ابتداءً من سليمان بن صرد الخزاعي في عين الوردة، والمختار بن أبي عبيد، حتى زيد بن علي.
وثار عبد الله بن الزبير وعبد الرحمان بن الأشعث ويزيد بن المهلب.
فهل رأيت بين هؤلاء مَن لم يكن عربياً ومن أُسرة عربية معروفة؟!
هل فيهم مَن هو مولى يريد الكيد للعروبة والإسلام وإعادة مجد فارس ودين ماني ومزدك؟!
أكانت الثورة لهواً ومجلس شراب، فثاروا وتبعهم الناس يتدافعون وراء كأس خمر وسماع مغنٍّ والتمتّع برقص جارية.
ليس السؤال لم ثاروا، لكن السؤال - لو لم يثوروا - لمَ لمْ يثوروا؟
ثاروا لأنّه كان لا بد أن يثوروا، وإلاّ جرّدناهم من أفضل صفات الإنسان وأكرمها، حين يظلم فيخضع ويستكين ولا يرفض ولا يتمرّد ولا يثور. وما أظن هذا ممّا يشرّف العرب ويرضي كبرياءهم وإن كان يرضي - كما يبدو - هؤلاء العروبيين الذين يقفون دائماً مع السلطة وينتصرون لها ويدافعون عن جرائمها، وينسون دائماً هذه الجماهير المضطهدة المظلومة ويلومونها ويتهمونها إن توجّعت أو صرخت أو تحرّكت، مع أنّها لا تختلف في عروبتها عن عروبة حكّامهم الظالمين لهم.
ولقد تساءلت: إن كان عروبيو هذا العهد من الكتّاب والمؤلّفين المدافعين عن بني أُميّة أصرح عروبة، وأشد اعتزازاً بها ودفاعاً عنها من ابن الزبير وابن الأشعث وابن المهلب، لولا هذا الجهل والحمق والغباء الذي يجعل كل ثائر في نظرهم ضد سلطة عربية، شعوبياً أو مخدوعاً بها أو مسخراً منه.
هناك كان الفساد، ومن هناك سرى إلينا، ومعه اتهام لكل مَن يحاول إصلاحاً أو يدعو - عند اليأس - إلى ثورة، بأنّه خارج عن الدين أو شعوبي، أو عميل بلغة العصر، يريد هدم الإسلام والعروبة و (قيم) و (تقاليد) الإسلام والعروبة. ويا بؤسها من قيم وتقاليد متخلفة، يراد لها أن تقودنا اليوم، وقد فشلت قبل خمسة عشر قرن. ولم تكن - وما زالت - إلاّ سلاحاً بيد السلطة للقتل والقمع والإرهاب، كلما أحسّت سخطاً، أو خافت تمرّداً أو ثورة للإطاحة بها والتخلّص من ظلمها.
وأنتقل الآن إلى موقف الموالي في ذلك العصر، وهم أصل الشعوبية موضوع حديثنا.
ولقد رأينا العرب يثورون بعدما تعرّضوا للظلم وذاقوا مرارته. لم يمنعهم من الثورة أنّ الحكّام عرب مثلهم، وهذا حق مشروع لهم ولغيرهم.
ولكنّي أحسب أنّ ظلم الأمويين لم يصل العرب إلاّ بعد أن مرّ بالموالي ولم ينل منهم قدر ما نال من الموالي وبالغ في إهانتهم والإساءة إليهم.
بل إنّ معاوية بن أبي سفيان عزم في وقت ما على أن يقتل شطر الموالي، ويدع الشطر الثاني لإقامة السوق وعمارة الطريق. ولم يثنه عن عزمه على قتلهم إلاّ الأحنف بن قيس سيّد تميم البصرة الذي نهاه عنه ونصحه بعدم إمضائه (1) .
وليشكر الموالي الحاجة إليهم في إقامة السوق وعمارة الطريق التي صرفت القتل عن شطرهم، وليشكروا هذا السيد النبيل الذي صرف القتل عنهم كلهم. فلولاهما لكان لمعاوية معهم شأن قد لا يقف عند الشطر.
أترى من ذنب لهؤلاء المسلمين يستحقون به القتل بهذا الشكل؟ لا مَن ارتكب جرماً منهم، بل مَن ارتكب ومَن لم يرتكب، قتلاً على الهوية.
وبعد معاوية، هل سننسى الحجّاج وغير الحجّاج من جبابرة الأمويين الذين لم يحترموا العرب ولم يكفّوا عنهم، فكيف بهؤلاء الموالي الذين لا عصبية تحميهم ولا قبيلة تمنعهم وتدفع عنهم، وقد قتل أصحاب العصبيات والقبائل.
ماذا سيكون موقف هؤلاء حين تقوم ثورة ضد الحكم الأموي، وينضم إليها العرب وترفع شعار الدين والعدل والمساواة، حقاً أو رياءً لجمع الناس وحشدهم.
هل سيقفون مع الأمويين وفي صفّهم، يقاتلون مَن ثار على الظلم الذي هم أول ضحاياه؟
ما أظنني سأحتاج إلى التفكير والترجيح بين موقفين: أيّهما أدع وأيّهما آخذ.
وهكذا كان الموالي ينضمّون إلى الثوّار والثورات العربية عند قيامها في مواجهة السلطة. ينضمّون إليها وقد سبقهم للانضمام إليها والالتحاق بها العرب أنفسهم وإلاّ لما قامت. فما كان الموالي بقادرين على أن يقوموا هم بثورة في العصر والظروف التي نتحدث عنها.
ثار الخوارج وانضمّ إليهم الموالي، وثار المختار وانضمّ إليه الموالي، وثار ابن الأشعث وانضمّ إليه الموالي.
____________________
(1) العقد الفريد لابن عبد ربّه , تحقيق محمد سعيد العريان، نشر دار الفكر ج3 ص326 - 327.
فهل تحوّلت هذه الثورات إلى ثورات شعوبية أو لخدمة أغراضها أو لتنفيذ مآربها، لمجرّد انضمام عدد من الموالي إليها؟
لماذا لا تسمّى باسمها الذي تستحق؟ أنّها ثورات عربية قامت بقيادات عربية وجماهير عربية في بيئة عربية. لكنّها ليست بعيدة عن الإسلام والمبادئ السامية التي جاء بها، وما كانت تستطيع أن تكون بعيدة عنها وهي لم تقم إلاّ من أجله. ولو فعلت لتخلّى عنها العرب قبل غيرهم. فما كان هؤلاء يجهلون أنّ حكّامهم الذين يحاربونهم عرب مثلهم. لكنّهم يحاربونهم؛ لأنّهم ظلموا وجاروا واستأثروا، خلافاً لقيم الإسلام ومثله ومبادئه، وفي ذلك ما يبرّر الثورة ضدّهم. فالحديث عن الموالي ومحاولة جعل ثورات العرب من صنعهم، هو إهانة للعرب وازدراء بهم وحط من شأنهم، ورفع من شأن الموالي وإعطاؤهم ما لا فضل لهم فيه.
وهل كان العرب في ثوراتهم تلك بدعاً من الأُمم والشعوب؟ ألم تثر الأمم قبلهم وبعدهم على حكّامهم حين يتنكّبون طريق الصواب؟ وهل استمر حكم منذ قام وحتى اليوم لم يشهد ثورة أو ثورات قد تنجح وقد تفشل، ولكنّها تبقى رمزاً لحيوية الشعوب واحترامها لذاتها واستعدادها للقيام في وجه كل مَن يحاول المساس أو العبث بحقوقها.
أراني أطلت المسافة قبل أن أصل إلى مفهوم الشعوبية والأسباب التي دفعت إليه.
وقد آن لي أن أتناول الشعوبية في جوانبها التي ظهرت من خلالها في الحياة العربية الإسلامية.
وسأحاول الاختصار جهدي، فقد أطال المتقدمون وأطال المتأخّرون. حتى لو تكلّمت عن الشعوبية دون تحديد لمفهومها لما وجد القارئ صعوبة فيما أقصد إليه.
كان العرب في الجاهلية وبعدها في الإسلام، وحتى اليوم الذي نعيش في القرن الحادي والعشرين - عدا الفترة التي صاحبت بدايات الإسلام ولم تدم طويلاً - يفخرون بأنسابهم ومآثر أهلهم، بل كانت هذه الأنساب مدار فخرهم، منها يبدؤون وإليها ينتهون. ولو خيّر العربي بين أن يذم ويمدح أهله وبين أن يمدح ويذم أهله، لما تردّد في اختيار الأول.
فالعربي يفخر على ابن عمّه من نفس قبيلته بمآثر له ولآبائه لا يملكها الثاني ولا يجدها في آبائه.
وما أظننا نسينا فخر الفرزدق وتعاليه واستطالته على جرير. ولم يكن جرير من قبيلة أُخرى إنّما كان مثل الفرزدق من تميم ولا من فخذ آخر من تميم إنّما من حنظلة فخذ الفرزدق، لكن لم يكن بين آباء جرير مَن يسامي آباء الفرزدق، فليس له غالب ولا صعصعة ولا دارم.
وما أظنّنا نسينا شبيب بن البرصاء وأرطاة بن سهية وعقيل بن علفة وكلهم من مرة من ذبيان.
وإذا خرجنا من نطاق القبيلة الواحدة وما يدور بين أفرادها من فخر ومدح وهجاء إلى علاقات القبيلة بغيرها من القبائل. وجدنا الفخر والمديح - ولا فرق بينهما عندي إلاّ بالنسبة لمَن قيل فيه - أمضى وأبعد وأشد إيلاماً. لا يحده ما يحد الشاعر حين يهجو أحد أفراد قبيلته فلا يتجاوز - بلغة العصر - خطوطاً حمراء قد ينفذ منها خصومه من شعراء القبائل الأخرى في هجاء قبيلته، إذا ادعت ظروف إلى ذلك.
وقد تجاوزت هذه الظاهرة في العصر الأموي حدود القبائل فيما بينها، واتسعت حتى شملت ما يسمّيه النسّابون بالشعب. فهجا الكميت اليمن كلها بجميع قبائلها من مذحج وكندة وطي و و. وردّ دعبل بهجاء نزار كلها بجميع قبائلها من ربيعة ومضر وما تضم ربيعة ومضر.
وقبل هذا رأينا الأخطل التغلبي يهجو قبائل قيس فيتناولها قبيلة قبيلة.
وجاءت الفتوح كما ذكرنا بالموالي، ودخل هؤلاء الحياة العربية وعرفوا لغتهم وألفوا عاداتهم، ونظموا شعرهم، وانتسبوا إليهم حتى صار الواحد منهم يقال له التميمي أو العامري فلا يميّز عن ابن القبيلة إلاّ بعد إضافة بالولاء أو مولى لهم.
وبين هؤلاء الموالي مَن دخل الإسلام عن عقيدة وإيمان؛ فكان يرى للعرب حقّاً عليه بما ناله على يدهم من خير وهداية بالإسلام ومحمد الذي هو منهم، وفي ذلك ما يعصمه من كره العرب والحقد عليهم.
وبينهم مَن لم يدخل الإسلام إلاّ خوفاً أو طمعاً ورجاءً.
وكانت معاملة العرب المسلمين في بدايات الإسلام رقيقة مع الموالي، ليس فيها ما يثيرهم ويحفظهم، وقد شاركوهم الإسلام وأصبحوا بالولاء جزءاً منهم.
أمّا مَن أسلم خوفاً أو رجاءً دون أن يكون للإسلام تأثير في فكره وسلوكه، فقد كان سلطان الإسلام ما يزال قوياً حينذاك يمنعه من إظهار ما يخفي من كره وحقد للعرب أو الإسلام.
وانتهى عهد الراشدين، وبدأ الحكم الأموي واختلفت سيرة الحكّام وضعف تأثير الدين في النفوس.
وكان العرب وهم يفخرون على بعضهم، مع وحدة اللغة ووحدة الدار، ومع العروبة التي تجمعهم، لا يرون طبعاً لهؤلاء الأجانب ما يرون أو بعض ما يرون لأنفسهم. فهؤلاء رقيق لا يملكون من أمرهم شيئاً، أخذوا قسراً بحد السيف، إن أحسنوا إليهم فذلك فضل منهم، وإن أساؤوا معاملتهم فهم ملك لهم.
وبدأ العرب أو المتعصّبون منهم يظهرون احتقارهم للموالي وازدراءهم بهم، ويشعرونهم بتعاليهم عليهم، حتى كانوا لا يكنّون الموالي ولا يمشون في الصف معهم، وإن حضروا طعاماً قاموا على رؤوسهم، بل إنّهم ساووا بينهم وبين الكلاب والحمير حين قالوا لا يقطع الصلاة إلاّ ثلاثة: حمار أو كلب أو مولى.
وكان لا بد لهذا التغيّر في موقف العرب - وهو أمر معتاد لدى الشعوب الغالبة بالنسبة للشعوب المغلوبة - أن يوجد تغيراً مقابلاً لدى الموالي الذين كان أكثرهم من الفرس، لأسباب ربّما عرضنا لها فيما بعد.
ولن يصعب عليك أن تتصوّر ما يمكن أن يتخذه الموالي من موقف نتيجة إحساسهم بالمهانة، وقد برز بينهم الشاعر والأديب والمفكّر.
وضعف لدى الجيل الجديد منهم وازع الدين الذي كان يدفع آباءهم إلى حب العرب والاعتراف بفضلهم عليهم.
ومع ضعف الوازع الديني، وبعد أن هدأت سورة الخوف وذل الهزيمة؛ عاد هذا الجيل من الموالي إلى ماضيهم يستذكرونه ويعودون إليه، أو يعيدهم إليه ما هم فيه من حال جديدة وما يعيشونه من ذل المولى إزاء سيّده، ثم يقارنون بين ماضيهم وبين الحال التي صاروا إليها. ولم يكن ماضيهم بعيداً عنهم في الزمان ولا في المكان، وكانت لهم دولة وسيادة وسلطان.
وبدأت أصوات هنا وهناك تطالب بالمساواة بين العرب وبين باقي شعوب الأُمّة الإسلامية، فلا فضل لأُمّة على أُمّة، ولا لقوم على قوم إلاّ بالإسلام الذي ساوى بينهم، وهذا القرآن كتاب الله يقول:
( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ) .
وأكّد هذا، النبي محمد حين قال في خطبته في حجّة الوداع:
(أيّها الناس أن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتفاخرها بالآباء، ليس لعربي على عجمي فخر إلاّ بالتقوى كُلّكم لآدم وآدم من تراب) وغير هذا ممّا يحمل معنى المساواة بين المسلمين، وأنّه إن كان هناك من امتياز أو تفاضل فلن يكون بالآباء والأحساب، ولكن بالأخلاق وشرف النفس وكرم الفعال. ولم يكن الموالي يجرؤون في ذلك الوقت، على أكثر من طلب المساواة، وهو ليس قليلاً في عصر العصبية القومية والعصبية القبلية.
والى هنا والأمر يبدو في حدود المقبول، فليس فيه شطط ولا تجريح بالعرب، ولا حط منهم ولا إنكار لمآثرهم. وربّما كان يشاطرهم فيه بعض أتقياء المسلمين وذوي الدين منهم.
وهذه الشعوبية التي تذهب إلى العدل والتسوية بين الناس الذين هم كلهم من طينة واحدة وسلالة رجل واحد هو آدم، والتي يبحثها ابن عبد ربّه في العقد تحت عنوان: (قول الشعوبية وهم أهل التسوية) هي إحدى صورتين للشعوبية من حيث المضمون. وهي أولى صورتين من حيث التأريخ. إذ إنّنا سنرى بعد ذاك صورة أُخرى للشعوبية تختلف عن سابقتها كثيراً فلا تقف عند التسوية ولا تكتفي بها.
لكن ابن عبد ربّه يخلط خلطاً غريباً فيجمع الصورتين - على ما بينهما من فرق كبير - في حديث واحد فلا ندري عن أي منهما يتكلّم، فهو ينتقل من آدم أبي الجميع ومن ( ... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ) كشعار لأهل التسوية والقائلين به، إلى الصورة الثانية للشعوبية القائمة على ذم العرب، والحط منهم وذكر مثالبهم حين يتحدث بلا فاصل بين الاثنين، وتحت نفس العنوان المذكور (قول الشعوبية وهم أهل التسوية) عمّا وصل إليه الشعوبيون في المرحلة الثانية من الطعن على العرب والزراية بهم والتحقير لهم، وهي الصورة الثانية التي ظهرت فيها الشعوبية بعد ذاك.
ثم يعود إلى رد ابن قتيبة على الشعوبية ورد هؤلاء على ابن قتيبة. ولكنّه يختصر ابن قتيبة اختصاراً شديداً.
ويبدو أنّ المؤرّخين العرب لم يعيروا اهتماماً للمرحلة التي حصل فيها هذا الانتقال، وكيف بدأت الصورة الثانية بالظهور، وتدرّجت حتى بلغت أشد قسوتها وعنفها وحقدها الذي لا يواريه شيء؛ إذ كان اهتمام المؤرّخين منصبّاً في الأغلب على الذبّ عن العرب وتفنيد الطعون الموجّهة إليهم، وإبراز مآثرهم وتأكيد تفوّقهم على غيرهم من الشعوب الأُخرى.
على أنّنا نستطيع أن نقدّر أنّ هذه المرحلة برزت كحركة في زمن العباسيين، الذين اعتمدوا في إقامة دولتهم على عناصر فارسية، أو في الأقل على مشاركتهم. ففي هذه المرحلة استطاعت العناصر غير العربية والفارسية على وجه الخصوص، أن تتكلّم وتهاجم وتطعن بحرية لم تكن تجرؤ عليها في المرحلة السابقة خلال حكم بني أُميّة (1) .
ولكن ما هي أبرز النقاط التي دارت حولها المعركة، والتي تمسّك بها الشعوبيون في ردّهم وهجومهم على العرب ومحاولة سلب مآثرهم أو تحويلها إلى عيوب.
كان العرب يفخرون بالجاهلية ويفخرون بالإسلام.
____________________
(1) على أنّنا لا نعدم بعض مظاهر ه ذ ه الشعوبية عند عدد من الشعراء الفرس في العصر الأموي، فإسماعيل بن يسار يستنشده هشام بن عبد الملك، وهو خليفة، شعراً - وكان يظن أنّه سينشده مديحاً فيه - فينشده إسماعيل قصيدته الميمية التي منها أبيات تضمّنت مديحاً قوياً للفرس و غمزاً من العرب فيغضب هشام عليه.
وابنا إسماعيل ه ذ ا: إبراهيم ودعبل - غير دعبل الخزاعي - لكل منهما شعر في مديح الفرس. وك ذ لك يزيد بن ضبّة مولى ثقيف.
لكن ه ذ ه النزعة الشعوبية بقيت فردية ضعيفة خافتة، لم تستطع أن تتجاوز حدودها تلك، في عصر العصبية العربية وقوّة النفوذ والسلطان العربي.
وفي الجاهلية كانوا أحراراً لم يخضعوا لسلطة ولم يستذلّهم حكم ولم يملكهم حاكم، تميّزوا بالكرم والشجاعة والوفاء والغيرة وهي صفات قلّما نجدها عند غيرهم، كما تميّزوا بحدّة العاطفة وصفاء القريحة التي أنتجت شعراً لم يعرف لأُمّة من الأُمم.
والى جانب ذلك فإنّهم يفخرون بوضوح أنسابهم حتى كان الواحد منهم لا يقف عند تعداد آبائه قبل أن ينتهي إلى الجد الأعلى الذي تحمل القبيلة اسمه، ثم يستمر حتى يتصل بعدنان أو بقحطان.
ولست أريد أن أناقش هذه القضية من الناحية العلمية، ومقدار ما فيها من صواب وهل يقرّها العلم أم لا، فذلك أمر آخر، لكنّها كانت عند العرب واقعاً لا مجال لمناقشته والشك فيه، وعلى أساسه كانت تقسيماتهم القبلية وقربهم أو بعدهم من بعض وتعصّب بعضهم لبعض.
أمّا فخرهم بالإسلام فلا يحتاج إلى دليل، فالقرآن نزل بلغتهم العربية، والنبي الذي نزل عليه كان عربياً منهم، والذين تحمّلوا أعباء الإسلام ونهضوا به وهو ضعيف، وجاهدوا وقاتلوا وقتلوا وعُذّبوا وتركوا أوطانهم وهاجروا هم العرب. والذين حملوه إلى الأُمم الأُخرى وقاتلوا وقتلوا عليه حتى أسلمت وتركت ما كانت فيه من دين هم العرب أيضاً.
وفي كل ذلك ما يمنحهم امتيازاً على الشعوب الأُخرى أن تقر وتعترف به وتخضع له، وقد أصبحوا موالي لهم. أخذوهم أسرى ولو أرادوا قتلهم لقتلوهم. فليس لهم أن يضيقوا بحالهم أو يقيسوا أنفسهم بالغالبين المنتصرين بدينهم وحربهم.
والحق أنّ العرب لم يكونوا مغالين ولا متزيدين فيما يقولون، ولم يكن فيهم ما يغيظ الآخرين ويحفظهم أو يثير حقدهم، لو بقي ذلك في حدوده ولم يخرج من الاعتزاز إلى التحدّي، ومحاولة سلب الشعوب الأُخرى مزاياهم وإنكارها عليهم، وتذكيرهم دائماً بأنهم دونهم. فهذه الشعوب لها هي أيضاً مزايا وصفات تعتز وتفخر بها كما يفخر العرب، وتدافع عنها وتحرص عليها وعلى التذكير بها كلما دعتهم الحاجة واضطروا إلى التذكير بها.
وكان العصر الأموي عصر العصبية، بين العرب أنفسهم: نزار واليمن، وربيعة ومضر، وبكر وتميم. وبين العرب وبين الأجناس الأُخرى خصوصاً الفرس. وهذه الأجناس على اتصال يومي بالعرب، يرونهم ويعاملونهم في الصباح والمساء، في المدينة وفي الشارع وفي السوق.
وكان الحكم نفسه يدفع إلى هذه العصبية ويشجّع عليها ويذكي نارها، كما ذكرنا.
وأحسب أنّ وضعاً كهذا لا بد أن ينفجر يوماً ما بشكل ما إذا تهيأت الفرصة.
وبدأت فكرة المساواة التي تحدثنا عنها، وهي أُولى صور الشعوبية وقال الفرس: إنّهم أصبحوا شركاء للعرب في الإسلام الذي لا يفرّق بين مسلم وآخر إلا بالتقوى، وأنّه قد يفضل العجمي العربي إذا كان الأوّل أتقى لله وأقرب إلى مرضاته.
وإذا كانت هذه النزعة القائمة على المساواة ترضي ذوي الدين من الطرفين: العرب والموالي، فإنّها لم تكن كذلك بالنسبة لهذا الجيل من شباب العرب ومتعصّبيهم وأصحاب الموالي منهم. يقابلهم على الطرف الآخر جيل جديد من الموالي الذين ابتعدوا عن الدين، وعادوا إلى تراثهم القومي يستلهمونه ويبعثونه حياً، يتسلّحون به لمواجهة ما يفخر به العرب. فيقابلون فخراً بفخر، ومآثر عربية بمآثر فارسية.
ثم زادوا فلم يكتفوا بهذا ولم يقفوا عنده فتجاوزوه إلى ما كان من فضائل للعرب وبدؤوا بها ينقضونها ويغضّون منها ويحطّون من شأنها، الواحدة بعد الأُخرى ويقارنون بينها وبين ما كان لهم من فضائل لا تقاس بها في نظرهم.
وكانوا يأخذون أحياناً الحالة الفريدة إذا كانت في غير صالح العرب فيعمّمونها ويجعلونها القاعدة أو الحالة العامّة، على عكس ما إذا كانت في صالح العرب فإنّهم يحاولون أن يقلّلوا من شأنها ويجعلوا منها حالة خاصة. كل ذلك لتأكيد تفوّق الموالي على العرب.
وهنا تكون الصورة الثانية للشعوبية قد اكتملت، وهي التي ينصرف إليها الذهن الآن عند ذكر الشعوبية.
وأظن من المناسب أن نذكر بعض ما أورده ابن قتيبة في العقد على لسان العجم وهم يردّون دعوى العرب بتقدّمهم على غيرهم، ويقابلون ذلك بما للعجم من مفاخر لا يمكن إنكارها.
وأظن من المناسب أيضاً أن نقسّم الحديث هنا إلى قسمين: يتناول الأوّل: الجاهلية وإنكار الشعوبية على العرب فضاءلهم، ومحاولة نقضها والإفاضة في بيان عيوبهم.
ويتناول الثاني: دعاوى الشعوبية في الإسلام وما يتعلّقون به من ذلك.
ولنبدأ كما قلت بالجاهلية: فماذا يقول الشعوبيون فيها ممّا جاء في العقد (... أخبرونا إن قالت لكم العجم هل تقدرون الفخر كله أن يكون ملكاً أو نبوّة فإن زعمتم أنّه ملك، قالت لكم وإنّ لنا ملوك الأرض كلها من: الفراعنة والنماردة والعمالقة والأكاسرة والقياصرة … وإن زعمتم أنّه لا يكون الفخر إلاّ بنبوّة فإنّ منّا الأنبياء والمرسلين قاطبة من لدن آدم ما خلا أربعة: هوداً وصالحاً وإسماعيل ومحمد … ولم تزل الأُمم كلها من الأعاجم في كل شق من الأرض، لها ملوك تجمعها، ومدائن تضمّها، وأحكام تدين بها، وفلسفة تنتجها، وبدائع تفتقها في الأدوات والصناعات، مثل صنعة الديباج ولعب الشطرنج … ومثل فلسفة الروم... والإسطرلاب...
ولم يكن للعرب ملك يجمع سوادها ويضم قواصيها ويقمع ظالمها وينهى سفيهها، ولا كان لها قط نتيجة في صناعة ولا أثر في فلسفة إلاّ ما كان من الشعر وقد شاركتها فيها العجم).
ثم ينتقل بعد أن يعدّد مآثر العجم إلى الهجوم المباشر على العرب فيصفهم بأنّهم كـ (الذئاب العادية، والوحوش النافرة، يأكل بعضها بعضاً ويغير بعضها على بعض، فرجالها موثقون في حلق الأسر ونساؤها سبايا مردفات على حقائب الإبل، فإذا أدركهن الصريخ استنقذن بالعشي وقد وطئن كما توطأ الطريق المهيع فخر بذلك شاعر فقال:
وأوثق عند المردفات عشيّة
فقيل له ويحك وأي فخر لك أن تلحق بالعشي وقد نكحن وامتهن.
وقال جرير يعيّر بني دارم يوم رحرحان:
وبرحرحان غداة كبّل معبد |
نكحت نساؤكم بغير مهورِ |
وقال عنترة لامرأته:
إنّ الرجال لهم إليكِ وسيلة |
أن يأخذوك تكحّلي وتخضّبي |
وسبى ابن هبولة الغسّاني امرأة الحارث بن عمرو الكندي فلحقه الحارث فقتله وارتجع المرأة وقد كان نال منها…
وسبت بنو سليم ريحانة أخت عمرو بن معدي كرب.
وأغار الحوفران بن شريك على بني سعد بن زيد مناة، فاحتمل الزرقاء من بني ربيع ابن الحارث فأعجبته وأعجبها فوقع بها.
ويعود ابن قتيبة إلى نفس الموضوع تحت عنوان (قول الشعوبية في مناكح العرب):
(قالت الشعوبية إنّما كانت العرب في الجاهلية ينكح بعضهم نساء بعض في غاراتهم بلا عقد نكاح، ولا استبراء من طمث، فكيف يدري أحدهم مَن أبوه؟!
وقد فخر الفرزدق ببني ضبّة حين يبتزّون العيال في حروبهم في سبيّة سبوها من بني عامر بن صعصعة، فقال:
فظلّت وظلّوا يركبون هبيرها |
وليس لهم الا عواليهم ستر |
والهبير المطمئن من الأرض وإنّما أراد هنا …
وهكذا ننتهي من حديث ابن قتيبة عمّا توجّهه الشعوبية من طعون إلى العرب في الجاهلية. ولي عليه بعض الملاحظات التي يمكن اختصارها فيما يلي:
فأوّلاً: إنّ الحديث هنا لا يختص بالعرب والفرس وحدهم ولا يقابل بينهم، وإنّما يتحدث عن جميع الأُمم والشعوب الأُخرى من غير العرب: الفراعنة والأكاسرة والقياصرة و و، ويقابل بينها مجتمعة وبين العرب. فهو في هذا يضيف علماً إلى علم، وفنّاً إلى فن، وفلسفة إلى فلسفة. من كل أُمّة ما اتصفت به وبرعت فيه، ثم يجمع كل ما تحصّل لديه من ذلك ليقابل به العرب ويفاخرهم، وكأنّه يجعل العرب في جانب والعالم كلّه يومذاك في جانب. وليس في هذا أدنى حدود العدل.
وألاحظ ثانياً: أنّه كان للعرب في الجاهلية دول ذات حضارة، قد لا تكون في مستوى الإمبراطورية الفارسية أو الرومانية، ولكنّها دول على كل حال، وأظن آثارها أو بعضها ما تزال شاخصة في اليمن حتى اليوم.
على أنّ من مفاخر العرب: أنّهم لم تملكهم دولة ولم يخضعوا لسلطان، وأنّهم استطاعوا بالرغم من ذلك ومن دون هذه الدولة والسلطان، أن يهزموا أقوى إمبراطوريتين على وجه الأرض في ذلك العهد. وهذا ما يحسب للعرب لا عليهم.
أمّا عن قمع الظالم ونهي السفيه، فلقد كان في النظام القبلي الذي فرض مع الزمن حكمه، وأصبح له ما للقانون أو أكثر ممّا للقانون من حرمة ورعاية، ما يكفل قمع الظالم ونهي السفيه ويردّهما طوعاً أو جبراً عن الظلم والسفه إن أراداهما.
هذا فضلاً عمّا يحدثنا التاريخ عن بعض الاتفاقات التي تمّت بين عدد من القبائل، وأخذت ما يشبه شكل القانون الجماعي، كحلف الفضول الذي تمّ بين عدد من بطون قريش، وقام على مبادئ أخلاقية عالية: كنصرة الضعيف، وردع القوي، وإنصاف المظلوم وأخذ الحق له ممّن ظلمه، وغير ذلك من مكارم الأخلاق التي تجسّدها القوانين غير المكتوبة وتستند إليها.
ثالثاً: كما ألاحظ أنّ حديث الأنبياء خصوصاً ما يتعلّق بآدم لا يمكن قبوله في حال من الأحوال من أي طرف ادعاه، فهو أبو البشر، يتساوى فيه العجم وغير العجم من أي جنس ومن أيّة أُمّة أو شعب. فافتخار العجم فيه كافتخار العرب، لا يختلف عنه ولا يزيد عليه إلاّ إذا كان هناك آدم آخر لا ينتمي إليه العرب.
أمّا حديث النساء والسبي والنكاح وما شابه ذلك من طعون قد حصلت في مناسبة ما أو لسبب ما، فليس العرب ملائكة لا يخضعون لما تخضع له الأمم الأخرى من سنن، وغالب ومغلوب، وحب وكره وثأر، وما تجده شاذاً غريباً عندهم يوجب الذم تجد أكثر منه، وما لا يقارن به عند الأُمم والشعوب الأخرى، ويكفي أنّ الشعوبيين، مع كل بحثهم واجتهادهم في التفتيش عن مثل هذه المطاعن وتطلبها، لم يجدوا أمامهم إلاّ حالات معدودة هي التي ذكروها وتمسّكوا بها في هجومهم على العرب.
لكن مَن الذي ساعد الشعوبيين في معرفة هذه المطاعن الأخلاقية، على افتراض صحّتها، وأنّها ليست مجرّد هجاء في شعر يكذب فيه الشاعر أو يبالغ على الأقل؟ ومَن الذي دلّهم على هذه الفضائح ومهّد الطريق لإطلاعهم عليها، وشنّ هجومهم على العرب بسببها.
إنّ الذي ساعد الشعوبيين على ذلك عاملان وجدهما هؤلاء أمامهم؛ فاستغلاهما وأفادا منهما في النيل من العرب، وهدم ما قام عليه فخرهم من الشجاعة وحفظ النسب والغيرة على المرأة وعدم التعرّض لها والاستماتة في الدفاع عنها.
وأوّل هذين العاملين الشعر العربي نفسه.
فالشعر في الجاهلية كان مرآتها يعكس حياة العرب فيها من خير وشر، وحرب وسلم وغنى وفقر، وحكمة وعبث وحب وكره، لا يترك صغيرة ولا كبيرة ممّا يسر أو يسوء إلاّ سجّلها وأشار إليها.
وكانت حياة القبائل - وهذا ليس سراً - حياة لا تخلو من قسوة وشدّة في صحراء تقل فيها المياه ويقل معها الزرع والنبات.
ولم تكن القبائل كلها كما يتصوّر البعض رحلاً لا منزل لهم، يجوبون الصحراء ليلاً ونهاراً شتاءاً وصيفاً. لا يحلون في أرض إلاّ ليتركوها إلى أخرى. لقد كان لكل قبيلة أرضها ومساكنها ومياهها. ولو راجعت الشعر العربي وكتب المعاجم لرأيتها تقول: وهو واد لبني فلان، أو منزل لبني فلان، أو عين لبني فلان، أو جبل في أرض بني فلان. وإن كان هذا لا يمنع من الانتجاع إلى منازل أخرى، خصوصاً حين الجدب وانحباس المطر. فكانت بعض القبائل تتحوّل من منازلها إلى منازل قبائل أخرى، وهو ما يسبب أحياناً قتالاً بين تلك القبائل.
لكن هذا ليس السبب الوحيد للقتال بين القبائل، فحياة البداوة تفرض قيماً معيّنة لا تجدها في الحاضرة وليست دون ما سبق إثارة للقتال وإغراءً به.
ثم هل بسبب البداوة ثارت الحروب بين الدول المتجاورة وغير المتجاورة في مختلف عصور الإنسانية؟ وهل كان القتال حكراً على العرب دون الأمم والأجناس الأخرى؟
وإذا كانت القبيلة تحتاج إلى الفارس في معاركها يحمل سيفه ورمحه يقاتل أعداءها ويرد عدوانهم عنها، فإنّها تحتاج وبنفس الدرجة من القوّة، إلى الشاعر يحرّض ويذمر يمدح ويذم ويفخر ويهجو، لا القبائل الأخرى فقط، وإن كان هذا يأتي بالمكان الأوّل، بل حتى مَن ينتمي إلى نفس قبيلة إذا قصّر في واجبه نحوها عند حاجتها إليه.
والشاعر، وهو يمدح ويذم ويفخر ويهجو، ليس رجل دين يفكّر في آخرته، بل رجل لسان وسلاح قبيلة يقول ما تفرضه عليه المناسبة، وينفث به صدره ويأتي على لسانه في لحظة القول، وقد يصدق فيما يقول وقد لا يتقيّد بحدود الصدق فيزيد أو يبالغ أو يتهم، وقد يرد إلى ذهنه المعنى فلا يتركه أو يختلق واقعة لا أصل لها لكسب المعركة مع شاعر آخر، أو قبيلة أخرى ممّا يراه أوجع لها وأبلغ في أذاها.
ولهذا فإذا كان (الشعر العربي هو ديوان العرب) صحيحاً من حيث إنّه يصوّر جميع نوازعهم في حبّهم وبغضهم وما يخالج نفوسهم، وهم يعيشون الحرب والسلم والجدب والرخاء والنصر والهزيمة. لكن هذا الديوان يحتاج في رأيي إلى مراجعة، وهي مهمّة صعبة على مَن لا يعرف عميقاً حياة العرب آنذاك.
ولا أريد بالمراجعة أن نعمد إلى حذف كل ما نعدّه عيوباً ومطاعن ونلغيها تنزيهاً للعرب وتعصّباً لهم، فذلك كذب وتشويه وتزوير لحياتهم وللتأريخ، ليس أكثر منه محاولة تجريدهم من حسناتهم وسلبهم إيّاها.
وإنّما أريد أن أقول ببساطة: إنّ بعض الشعراء لم يلتزموا الصدق، لا سيّما في الهجاء، فأطلقوا العنان لخيالهم ولسانهم دون وازع من خلق أو دين.
هنا لا بد من الرجوع إلى الوقائع الأخرى الثابتة لمعرفة صدق الشاعر في القول وتصحيح ما كذب فيه.
ولأضرب لذلك مثلاً بجرير وهو يهجو الفرزدق ويعيّره بأُخته جعثن، وهي في نفسها من فضليات النساء، وهي في أُسرتها من جهة الأب والأم، لا يمكن أن يقاس بها من قريب أو من بعيد ابن الخطفى وأُسرته، وقد تعرّض لها جرير واتهمها في شعره.
هذا الشعر بصدقه حيناً وكذبه حيناً أو أحياناً قدّم للشعوبية سلاحاً ماضياً يقاتلون العرب به، ويردّون دعاواهم وينقضونها عليهم دون أن يتعرّضوا للاتهام بالكذب.
وجد الشعوبية شعراً عربياً قاله شعراء عرب يهجون عرباً مثلهم، ويتهمونهم بنسائهم وأخواتهم وآبائهم تارة، وبالجبن والبخل واللؤم تارة، فما الذي يمنعهم من اللجوء إلى هذا السلاح يهاجمون به مَن يهاجمهم، ويستصغرهم ويسخر منهم ويحط من قدرهم، ولا يجد لهم في الفخر موطئ قدم؟
وأظن الشعراء العرب لو علموا بما سيكون من شأن لشعرهم ذاك، وبالحرج الذي سيتعرّض له العرب كلهم؛ إذن لحذفوا الكثير ممّا قالوه أو لم يقولوه أصلاً.
لكن هذا الشعر في تعرّضه لتلك الوقائع، كان يقتصر في الأغلب على الإشارة إليها ويكتفي بذكرها، فهو بطبيعته لا يستطيع أن يتجاوز إلى التفاصيل ويبعد فيها، فذلك شأن الكتب لا الشعر، والكتّاب لا الشعراء الذين قد يذهب بجمال شعرهم وسحره وروعته دخوله في تفاصيل الحوادث التي يتعرّض لها.
وهنا وجد الشعوبيون سلاحاً آخر أمضى وأفتك وأقدر على طعن الخصم وتمزيقه، قدّمه لهم العرب أيضاً كما قدموا لهم من قبل سلاح الشعر. هذا السلاح الآخر يتمثّل في كتب المثالب التي بدأها العربي زياد بن أبيه، أو زياد بن أبي سفيان كما أراد معاوية، وهو أوّل مَن ألّف في مثالب العرب كما يتفق المؤلّفون، وفصّل فيها ولم يترك شيئاً ممّا يسئ إليهم أحياءً أو أمواتاً إلاّ ذكره وأتى عليه وأفاض فيه، يساعده في ذلك قربه من الجاهلية وتوفّر المال لديه، يوزعه على مَن يأتيه بخبر أو حادثة فيها طعن على العرب أو مس بشرفهم وكرامتهم.
يقول أبو الفرج في الأغاني: (... إنّ أصل المثالب زياد لعنه الله فإنّه لمّا ادعى إلى أبي سفيان وعلم أنّ العرب لا تقر له بذلك مع علمها بنسبه ومع سوء آثاره فيهم؛ عمل كتاب المثالب فألصق بالعرب كلها كل عيب وعار وحق وباطل...) (1) .
ويقول أبو عبيد البكري في سمط اللآلي: (وكتاب المثالب أصله لزياد بن أبيه فإنّه لمّا ادعى أبا سفيان أباً علم أنّ العرب لا تقر له بذلك، مع علمها بنسبه فعمل كتاب المثالب وألصق بالعرب كل عيب وعار وباطل وأفك وبهت) (2) .
ويقول ابن قتيبة: (وقد كان زياد بن أبي سفيان حين كثر طعن الناس عليه وعلى معاوية في استلحاقه؛ عمل كتاباً في المثالب لولده، وقال: مَن عيّركم فقرعوه بمنقصته، ومَن ندّد عليكم فأبدهوه بمثلبته فإنّ الشر بالشر يتّقى والحديد بالحديد يفلح) (3) .
ويقول ابن النديم: (أوّل مَن ألّف في المثالب كتاباً زياد بن أبيه، فإنّه لمّا ظفر عليه وعلى نسبه عمل ذلك ودفعه إلى ولده وقال استظهروا به على العرب فإنّهم يكفّون عنكم) (4) .
فزياد بن (أبي سفيان) إذن هو أوّل مَن ألّف في مثالب العرب، وكشف فضائحهم، وأظهر عيوبهم فأكّد دعاوى الشعوبية فيما بعد ضد العرب، وأعطاهم السلاح الذي سيقاتلونهم به.
وإذا كان زياد يريد أن يثأر لنفسه ويشفي غيظه ممّا يرمي به من سمية وعبيد، بالطعن في أنساب العرب وإبراز كل ما يشينهم ويسئ إليهم، فما بال هشام بن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي العربي، يأمر النضر بن أبي شميل الحميري وخالد بن سلمة المخزومي أن يضعا كتاباً في مثالب العرب.
فإذا كان الأمير أخو الخليفة يكتب في مثالب العرب في النصف الأوّل من القرن الأوّل الهجري (5) .
____________________
(1) الأغاني ج20 نسب ابن أبي عيينة وأخباره ص77.
(2) سمط الآلي في شرح الآمالي لأبي عبيد البكري، ط لجنة التأليف والترجمة والنشر 1936 ص807 - 808.
(3) رسائل البلغاء لمحمد كرد علي - لجنة التأليف والترجمة والنشر - ط ثالثة ص346.
(4) الفهرست - الفن الأوّل من المقالة الثالثة. طبعة دار المعرفة - بيروت - لبنان ص131.
(5) توفّي زياد عام 53.
وإذا كان الخليفة نفسه يأمر بوضع كتاب في مثالب العرب في أوائل النصف الأول من القرن الثاني (1) .
فهل سيقبل (الأمويون) بأن نتهم الخليفة و(أخا) الخليفة بأنّهما كانا أول الشعوبيين، وأول مَن مهّد الطريق للشعوبية ورفع لواءها؟
ولِمَ سنلوم الآخرين، عرباً أو غير عرب، إذا ما كتبوا هم في مثالب العرب، حتى لو زادوا وبالغوا وأضافوا، وقد سبقهم إلى ذلك أمير وخليفة عربيان مسلمان.
وهكذا فقد تبعهما يونس بن محمد بن أبي فروة، ووضع كتاباً في مثالب العرب وعيوب الإسلام بزعمه وصار به إلى ملك الروم فأخذ منه مالاً (2) وأظنّك تعرف أنّ يونس هذا هو والد الربيع بن يونس - عند مَن يصحّح أبوّته له - وجد الفضل بن الربيع اللذين وزرا وحجبا وتوليا أعلى المناصب في زمن المنصور والمهدي والرشيد.
ثم كتب هشام بن محمد بن السائب الكلبي كتابه في المثالب، وهشام عربي صليبة من كلب غير مغموز في نسب ولا متهم بشعوبية.
كما كتب كذلك الهيثم بن عدي وهو من طي.
فأي خطر وأي جديد فيما سيكتبه بعد ذاك أبو عبيدة أو علان الشعوبي، أو غيرهما من غلاة الشعوبية والمتعصّبين منهم ضد العرب، وهم لن يزيدوا ولن يتجاوزوا العرب فيما كتبوه عن العرب قبلهم بأكثر من قرن.
____________________
(1) توفّي هشام بن عبد الملك عام 125.
(2) آمالي المرتضى تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية ج1 ص132.
لقد ساعد العرب في شعرهم وفي كتبهم عن مثالبهم الشعوبية بما لم يكن سهلاً عليهم معرفته والاطلاع عليه. ولو عرفوه واطلعوا عليه عن غير طريق العرب أنفسهم لربّما ردّ عليهم بأنّه من صنعهم ووضعهم، أو لاتهموا على الأقل بالإضافة والتزيد فيه، فقام العرب نيابة عنهم بهذه المهمّة التي لن يتهموا فيها ولن يكذبوا.
كان الشعر، وأنا هنا أتحدث عن شعر الهجاء بصورة خاصة، أول سلاحين أهداهما العرب للشعوبيين.
ثم جاءت كتب المثالب فأكملت ما بدأه الشعر من صورة قاتمة للعرب، وأخلاق العرب وقيم العرب، وكل ما قام عليه فخرهم واستند إليه.
فهل لنا أن نلوم الشعوبيين على استعمال سلاح قدّمناه لهم دون أن يطلبوه ويبحثوا عنه؟! أم الملوم مَن وضع السلاح في أيديهم ثم وقف من بعد ليلعن ويسب ويتهم هؤلاء الذين استعملوا السلاح وقاتلوا به، وهم يخوضون معركة معه.
وملاحظة أخيرة أود أن أشير إليها قبل أن أختم حديثي عن الشعوبية، هي أنّ هؤلاء الشعوبيين، الزنادقة منهم وغير الزنادقة، قد أصبحوا جزءاً من النظام القائم آنذاك، وارتبطت مصالحهم به واتسع نفوذهم في ظلّه، فلم يثوروا عليه ولم يشاركوا في ثورة ضدّه، مكتفين من شعوبيتهم بالتذكير بماضيهم العريق ومجدهم القديم في مقابل حاضر ومجد لا عراقة ولا قدم لهم. لقد قامت أكثر من ثورة كثورة بابك، وبعدها ثورة المازيار، فلم ينضم إليهما ولا إلى غيرهم، أي من هؤلاء: أسراً أو أفراد. لقد كانت شعوبيتهم شعوبية فكر أو، إن شئت، شعوبية ذكريات تجاوزها المحاربون ولم يكونوا في حاجة إليه.
وأحسبني انتهيت الآن من هذا الفصل لانتقل إلى بحث العلاقة بين الزندقة والشعوبية، وهو ما يؤلّف الفصل الثاني وهو أيضاً آخر فصول الكتاب.
القسم الثالـث:
العـلاقـة بين الزندقة وبين الشعـوبية
هل هناك علاقة بين الزندقة وبين الشعوبية وما هو مدى هذه العلاقة إن وجدت؟ فقد تحدّث المؤرّخون كثيراً وربطوا كثيراً بين الاثنين، حتى كأنّك وأنت تتحدث عن إحداهما تتحدث عن الأُخرى.
أمّا من الناحية النظرية فليس هناك من علاقة بين الزندقة وبين الشعوبية، ولا يجوز الخلط بينهما، فهو خلط بين حركتين منفصلتين في منطلقاتهما الفكرية بل متباعدتين أو متعاديتين. وما أظن أحداً يجهل فرق ما بين الاثنين.
ما الذي يجمع يحيى بن زياد، أو عبد الكريم بن أبي العوجاء، أو أبا العلاء المعري إلى سهل بن هارون، أو حميد بن البختكان، أو علان الشعوبي؟!
الزندقة نزعة فكرية فردية تتجه إلى أعلى. تنكر الله أو تشك فيه أو تنكر نبوّة محمد والنبوّات. وهي في إنكارها أو شكّها لا تنكر أو تشك بإله العرب لتعترف بإله الفرس، ولا بنبوّة محمد، لتقر بنبوّة ماني أو مزدك؛ فهي فوق الشعوب والأجناس ومستقلّة عن الشعوب والأجناس.
إنّها حين تنكر الصانع أو تؤمن بالدهر وترفض الجنّة والنار، تنطلق من فكر عام صحيح أو مريض لا يهم، ولكنّه فكر لا يميّز بين صانع ينكره وصانع يؤمن به، ولا بين جنّة يرفضها وجنّة يطلبها.
وقبل زنادقة الإسلام والخلط بينهم وبين الشعوبية، كان هناك في الجاهلية زنادقة تحدث المؤرّخون عنهم، وأشرنا إليهم في بداية الكتاب.
وقبل زنادقة الإسلام وقبل الشعوبية بما يقارب القرنين من الزمان، قال ابن الزبعرى العربي القرشي الجاهلي:
حياة ثم موت ثم بعث |
حديث خرافـة يـا أم عمـرو |
وقال الآخر وهو أبو بكر بن الأسود من كنانة:
يخبرنا ابن كبشة أن سنحيـا |
وكيف حياة أصداءٍ وهامِ |
وأيّ إلحاد أو زندقة، حتى في عصر الإلحاد والزندقة فيما بعد، أصرح وأوضح من هذا الإلحاد، يصرخ به غير مجمجم ولا خائف شاعران عربيان عاشا في الجاهلية، قبل أن تعرف الشعوبية والشعوبيون والمعركة مع الأمم والشعوب الأخرى؟!
فالزندقة لم تنشأ في الإسلام ولم يسبق إليها الزنادقة (المسلمون)، وربّما كان الإغريق أولى أن يعتبروا قادة الفكر (الزندقي) في العالم.
لقد عرفها الفكر الإنساني إذن قبل الإسلام بقرون طويلة، فهي ليست مقرونة بزمان معيّن، ولا بشعب معيّن بقدر ارتباطها بالفكر في مرحلة من مراحل نموّه وتطوّره ما دام هناك فكر ينمو ويتطوّر.
أمّا الشعوبية فهي حركة قومية سياسية ثقافية، أفرزها ظرف معيّن نشأ عن صراع حضاري بين شعب غالب منتصر وشعوب مغلوبة مهزومة، ثم انحصر أو هكذا عرف، في الصراع بين حضارتين متجاورتين، كانت إحداهما في الجاهلية هي صاحبة القوّة والنفوذ والسلطان، فذهبت مع ظهور الإسلام القوّة والنفوذ والسلطان الذي انتقل من الفرس إلى العرب. وكان هذا بالإضافة إلى الأسباب الأخرى التي عرضنا لها ممّا أشعل الصراع ودفع به إلى أبعد غاياته وخلق هذه الحركة التي اصطلح على تسميتها بالشعوبية.
لكن هاتين الحركتين المستقلتين في الأصل، يفقدان شيئاً من استقلالهما ويقتربان من بعضهما هنا بفعل عدد من العوامل، فإذا بنا أمام هذا الخلط الذي يجعل من الزندقة والشعوبية شيئاً واحداً أو يكاد.
وأظن قد آن لنا ونحن في نهاية بحثنا أن نشير إلى بعض الملاحظات التي نرجو أن تسهم في توضيح هذه الناحية، ويكفيها على أيّة حال أن تكون خطوة في هذا الطريق.
فمن هذه الملاحظات:
أنّ هذه الشعوبية نشأت كحركة ثقافية سياسية تمثّل رد فعل حضاري - إذا جاز التعبير - في وسط الموالي خصوصاً الفرس منهم، وهو أمر طبيعي؛ ذلك أنّ حركة كهذه تطالب في أضعف وجوهها بمساواة العرب بالشعوب الأخرى، وفي أشد وجوهها بتحقير العرب وتفضيل الآخرين عليهم، لا يمكن أن تنبت في بيئة عربية وبين العرب أنفسهم الشعب الغالب صاحب الحكم والسلطان وحامل القرآن والإسلام.
لكن هذا القول لا يصدق في عمومه. فإذا كانت الشعوبية قد نشأت وهو أمر طبيعي كما ذكرنا، في صفوف الفرس فإنّ الكثير من هؤلاء خصوصاً مَن نشأ منهم على الإسلام، قد بلغ في ورعه وتقواه وتمثّله الإسلام ديناً وسلوكاً حداً بعيداً.
لقد شارك هؤلاء المسلمون الجدد من الموالي والفرس، العرب المسلمين في قتالهم لرفع راية الإسلام وبسط رقعته، ثم دافعوا عنه وأيّدوه وردّوا على خصومه حتى تجاوزوا في ذلك العرب أنفسهم. مَن منّا يستطيع أن ينسى الحسن البصري وواصل بن عطاء وأبا حنيفة وغيرهم وغيرهم.
ثم ساروا شوطاً أبعد فكتبوا في العربية وعلومها وأدبها وشعرها وشعرائها، وكأنّهم من أبنائها ومن أبر أبنائها، قاطعين كل صلة لهم بماضيهم بعد ما ذابوا في الدين الجديد واللغة الجديدة والبيئة الجديدة، التي منحتهم بديلاً عن ماضٍ لم يعد له في نفوسهم شيء، إلاّ ما ينقله المترجمون لهم.
وأمامك أسماء المؤلّفين أمامك أسماء المؤلّفين في مختلف ميادين الفكر في مختلف ميادين الفكر الإسلامي العربي، وقد سمعت الكثير منه، وأظنّك ستدهش إذا علمت أنّ غير العرب منها أكثر من العرب. وأظنّك ستدهش أكثر إذا علمت أنّ الذين تولّوا الدفاع عن العرب ورد مطاعن الشعوبية، هم من هذه الشعوب التي اشتق منها اسم الشعوبية. ويكفيك منهم الجاحظ وابن قتيبة وابن عبد ربّه.
وأريد أن أقف قليلاً عند أوّلهم الجاحظ الذي ترك كل ما يوجّه إلى العرب من مطاعن، وأمسك بالعصا يقلبها ويقلب معها أسماءها وصفاتها كما يريد، فلا يترك صفة لها ولا شيئاً يتصل بها، أو يصنع منها أو له بالعصا علاقة من قريب أو بعيد إلاّ وأتى عليه تفصيلاً، وخاض فيه وفيما يجده في الطريق إليه مخصّصاً من كتابه البيان والتبيين أكثر من مائة صفحة كاملة للعصا. ولم تكن العصا إلاّ واحداً من المطاعن التي تأتي في آخر السلم ممّا يأخذه الشعوبيون على العرب.
وما أحسب الجاحظ كان يريد أن يرد على الشعوبية في إظهار فوائد العصا، ولا أن يبيّن الوجه في اعتماد العرب عليها بقدر ما أراد أن يظهر براعته اللغوية واتساعه في معرفة كل ما يتصل بالعصا لغةً وأدباً شعراً ونثراً جاهليةً وإسلاماً. فهو يريد إظهار فضله لا فضل العصا التي كان يكفيه منها صفحة أو دون (1) .
ومن هذه الملاحظات أنّ عدداً كبيراً من الزنادقة، بأي معنى فهمت الزندقة وعلى أي وجه أخذته، كانوا عرباً خلّصاً لا شك في أنسابهم ولا في عروبتهم بل من أرفع وأعلى أسرهم. وقد سبقوا إلى الزندقة ابتداءً من أوّل ما عرف هذا الاصطلاح في التأريخ العربي، واستعمل للدلالة على انحراف عن الدين وفروضه بشكل من الأشكال.
____________________
(1) البيان والتبيين، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون ج3 ص 5 - 124 والغريب أنّ الجاحظ المدافع عن العرب والراد على الشعوبية، كان هو ومعه اثنان من العرب الخلص: ضرار بن عمرو وثمامة بن أشرس، يفضلون النبط على العرب كما ي ذ كر المسعودي في مروج ال ذ هب ج2 ص26. وما أظن المسعودي متهماً فيما ينسبه لهؤلاء الثلاثة من رؤوس المعتزلة، وهو نفسه من المعتزلة.
وعلى رأس هؤلاء الخليفة الأموي الوليد بن يزيد بن عبد الملك كما سبق، ومروان بن محمد بن الحكم آخر خلفاء بني مروان والملقب بالجعدي نسبة للجعد بن درهم مؤدبه.
ومن هؤلاء أيضاً - بعد هذا التأريخ - يحيى بن زياد الحارثي من بني الحارث بن كعب من مذجح ابن خال الخليفة السفّاح أول خلفاء بني العباس.
ومن هؤلاء معن بن زائدة القائد الأمير المعروف، وهو من سادات بني شيبان وخاله عبد الكريم بن أبي العوجاء الزنديق المعروف من بني سدوس من بكر بن وائل.
ومن هؤلاء روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب.
ومنهم واليه بن الحباب الأسدي ومطيع بن إياس الكناني.
ومنهم يعقوب بن الفضل الهاشمي، من أحفاد الحارث بن عبد المطلب بن هاشم وابن لداود بن علي بن عبد الله بن عباس وآدم بن عبد العزيز بن عمر بن العزيز.
ومن متأخّريهم أبو العلاء المعرّي أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي.
وما أظن بين هؤلاء وكثيرين آخرين لم أذكرهم، وكلهم عرب صرحاء ومن صفوة الأُسر العربية مَن يمكن أن يتهم بالشعوبية إلاّ في أضعف جوانبها أي جانبها الإنساني الذي يقوم على المساواة، وعدم تفضيل جنس على جنس أو أُمّة على أُمّة. وحتى هذا الجانب الضعيف ما أحسبك ستصادفه عند غير أبي العلاء، وربّما والبة ومطيع ويحيى الذين شغلهم الركض وراء اللهو واللذّة، عن العرب والفرس والمقارنة بينهم، وعن التفكير في غير هذه الحياة العابثة الماجنة لا يبغون لها بديلاً. وقد تكون هذه الحياة أو هذا الأسلوب فيها وراء غمز بعض المؤرّخين في نسب والبة العربي.
ويقابل هؤلاء بعض الذين عرفوا بالشعوبية، ولم يعرفوا بالزندقة: كآل طاهر بن الحسين، وآل سهل، وربّما أضيف إليهم البرامكة أحياناً.
وكيحيى بن علي المنجم المسلم المعتزلي الشعوبي، وسهل بن هارون، وأبي عبيدة، وعلان الشعوبي، وسعيد بن حميد بن البختكان، والخريمي الشاعر: اسحاق بن حسان، الذين أبغضوا العرب وتعصّبوا ضدّهم، وحاولوا تجريدهم من كل مفاخرهم وتفضيل الفرس عليهم (1) .
وبغض العرب والمغالاة فيه قد يسوق أحياناً إلى ما هو أبعد من مجرّد بغض للعرب، الذي هو في ذاته مرفوض، ليتناول الإسلام نفسه باعتباره إرثاً عربياً نبت وأزهر في صحراء العرب. وربّما كان هذا من بين الأسباب التي أدّت إلى الخلط بين الزندقة والشعوبية.
ولا أريد أن أسير أكثر في هذا الحديث، وليس معي من الوقائع والأسماء والأدلة غير الظن، الذي لا يغني في حديث أردناه خالصاً للعلم، مجرّداً عن الهوى، بعيداً عن التعّصب.
وفي الطرف الأقصى من هؤلاء الشعوبيين، تجد من ضمّ الزندقة إلى شعوبيته: كيونس ابن أبي فروة، وحماد الراوية، الذي لي فيه وفيما نحله وأضافته إلى شعراء الجاهلية، رأي يختلف عمّا يذهب إليه الآخرون، فأنا لا أرى فيه شعوبية وما أحسبه كان يقصد إفساد الشعر الجاهلي كوجه من وجوه الشعوبية، بقدر ما أرى فيه ممارسة لتجربة شخصية، وإظهاراً لبراعة ومقدرة على فهم الشعر والإحاطة بظروف الشعراء ومعرفة البيئة العربية؛ فهو لم يخرج على قواعد الشعر العربي ولا على أغراضه التي نظم فيها الجاهليون، وليس في عدد من الأبيات التي قالها محتذياً حذو الشعراء العرب، وسالكاً طريقهم عن معرفة وعلم، ما يفسد الشعر العربي ويعيبه بالكذب والتزوير، خصوصاً مع اتفاق النقّاد العرب السابقين في أنّه كان يعرف مذاهب الشعراء فيضع البيت أو الأبيات ولا يستطيع إلاّ الناقد البصير أن يميّزها.
فأيّة شعوبية في عدد من الأبيات يسير فيها على طريقة الجاهليين لا يتخطّاهم، يصف ما يصفون ويمدح ما يمدحون ويذم ما يذمّون. ولو تخطّاهم أو خرج على مناهجهم لسهل تمييز شعره وفرزه عمّا أضيف إليه، ولفضح نفسه قبل أن يفضحه النقّاد.
____________________
(1) وألاحظ أنّ ابن الرومي قد أفلت من الاتهام بالشعوبية، مع أنّه لم يكن أقل وضوحاً من غيره في الفخر بآبائه الروم والغمز من العرب، استمع إليه وهو يقول:
آبائِيَ الرومُ توفيلٌ وتُوفَلِسٌ |
ولم يلدنيَ رِبعيٌّ ولا شَبَثُ |
إنّ حماداً لم يكذب ولم يزوّر فيما تناول من نواحي الحياة الجاهلية، ولكنّه كذب فيمن أضاف إليهم ذلك عندما كان يضيف. ثم إنّه حتى في هذا الذي أضافه، لم يطعن في العرب ولم يسلبهم مزاياهم، ولم يعبهم أو يذمّهم أو ينسب إليهم ما يمكن اعتباره كذلك، ليقال إنّه استخدم قدرته وحذقه في معرفة الشعر العربي لخدمة أغراض شعوبية.
وما أظن ما أضاف، مهما بلغ أو بولغ فيه، يمكن أن يؤثر على صورة الشعر الجاهلي أو يغير في الحكم عليه أو في صدقه. وكل الصعوبة في تمييز شعر حماد متأتية من شدة مشابهته للشعر العربي الجاهلي شكلاً ومضمون.
ثم كم من الأبيات يستطيع هذا الـ (حماد) أن ينظم وينحل ويضيف، حتى لو تجرد لذلك وحده. والشعر الجاهلي شعر أمة كاملة تمتد من اليمن إلى العراق وخلال فترة تبلغ المئات من السنين.
قد يكون حماد شعوبياً يكره العرب ويطعن فيهم ويغض منهم، شأن الشعوبيين الآخرين، ولكن في غير هذا فأنا لا أرى شعوبية فيما ينسب إليه من إضافة شعر إلى بعض شعراء الجاهلية ولم يكن هو الوحيد فيه. فهذا يزيد ابن ضبة. يقول أبو الفرج نقلاً عن جماعة من مشايخ الطائفيين وعلمائهم أنه قال ألف قصيدة فاقتسمتها شعراء العرب وانتحلتها فدخلت في أشعاره (1) .
وهذا خلف الأحمر يقول عنه ابن النديم (وكان - يعني خلفاً - من أمرس الناس لبيت شعر وكان شاعراً بعمل الشعر على لسان العرب وينحله إياهم) فلم يتهمه أحد (2) .
وأبو عمرو بن العلاء. ينقل عنه النقاد شيئاً مما يأخذونه على حماد وإن لم يكن بنفس الكثرة، ولم يتهم بشيء مما اتهم به حماد ولا ببعضه. وابن داود بن متمم بن نويرة كان ينظم الشعر وينحله جده متمماً لينفق بعد ما استنفد ما قاله جده (3) .
ومن هذه الملاحظات أيضاً - وأظنني بعدت كثيراً عما بدأت - أن عدداً من الشعراء عرباً وغير عرب قد فتنتهم الحياة الجديدة بما تزخر به من فنون اللهو وضروب اللذة وسهولة الاستمتاع بهما وبما تفيض من سحر وجمال وهم المولعون بالسحر والجمال يتصيدونهما ويلهثون وراءهما وقد أتاحتهما هذه الحياة ويسرتها لهم.
____________________
(1) الأغاني ج7 ترجمة يزيد بن ضبة ص103.
(2) الفهرست لابن النديم - الفن الأوّل من المقالة الثانية.
(3) بل إنّ أبا الطيب اللغوي ي ذ كر أنّ أكثر ما يرويه أهل الكوفة من الشعر (مصنوع ومنسوب إلى مَن لم يقله).
فهل سنتهم أهل الكوفة بالشعوبية لنفس السبب الذي اتهمنا من أجله حماداً بها؟!
وقد يكون أبلغ في الدلالة من هذا، ما يرويه ابن سلام في طبقاته قائلاً: (فلمّا راجعت العرب رواية الشعر وذكر أيامها ومآثرها، استقل بعض العشائر شعر شعرائهم وما ذهب من ذكر وقائعهم. وكان قوم قلّت وقائعهم وأشعارهم فأرادوا أن يلحقوا بمَن له الوقائع والأشعار فقالوا على ألسنة شعرائهم...) طبقات ابن سلام ج1 ص46.
وكانت الحياة الجديدة بكل فنون لهوها ولذّتها وسحرها وجمالها بعيدة عن حياة العرب قريبة من حياة الفرس، أو هي حياة الفرس قد انتقلت إليهم أو انتقلوا إليها. لم يكن الحاضرون في مجالس اللهو عتبة بن الحارث ولا بسطام بن قيس. ولم يكن الحديث عن داحس والغبراء وشعب جبلة.
ولم يكن المكان حمى ضرية ولازرود. ولم يكن الورد شيحاً ولا قيصوماً. ولم تكن الجارية ابنة لربيعة بن مكدم ولا عقيل بن علفة. فماذا تريد أن يقول هؤلاء الشعراء عرباً وغير عرب، وما ذا يصفون وهم يجتمعون على شرب وجَوارٍ ورقص وغناء وورد وريحان.
هل يسوؤك أن يكونوا صادقين مع أنفسهم يصفون ما يجدون، ويحسون دون كذب ولا تزوير، ودون رحلة كاذبة مزوّرة عبر الزمان والمكان إلى برقة تهمه والدخول وحوقل، وهم لم يروها ولم يعرفوها، ولا تثير لديهم ما كانت تثيره لدى الجاهليين حين يقفون مطيّهم عندها، ويستنطقونها ويذرفون الدمع على مَن فارقوا فيها، وهم في ذلك صادقون يصفون أيضاً ما يجدون ويحسّون دون كذب أو تزوير. إنّهم لو فعلوا ذلك لسخروا من أنفسهم ولسخر الناس منهم، ولما كان لشعرهم هذا الخلود الذي يحظى به حتى اليوم ولما زاد على شعر بعض هؤلاء المعاصرين من المدرسة القديمة، وهم يتغزّلون بسعدى ودعد في شعرٍ غث ميت لا يثير عاطفة عند السامع؛ لأنّه لم يصدر عن عاطفة عند القائل.
قد يكون بين هؤلاء شعوبيون وقد يكون بينهم زنادقة، لكنّ الذي جمع بينهم ليس الشعوبية ولا الزندقة، فلم يكونوا يجتمعون ليسبّوا العرب ويصرفوا شعرهم إلى الطعن عليهم وإظهار معايبهم، ولم يكونوا يجتمعون لتأليف الكتب في إنكار وجود الله أو قول الشعر في التشكيك بنبوّة محمد.
ما جمعهم ليس هذا ولا ذاك بل المجون واللهو وطلب اللذّة بكل أشكالها، وهو مذهب في الحياة سبقوا إليه حتى من بعض عرب الجاهلية. ماذا كان يفعل امرؤ القيس والأعشى وطرفة، مع اختلاف الزمن والبيئة، غير ما كان يفعله والبة وأبو نواس ومطيع مع اختلاف الزمن والبيئة أيضاً؟
وما عليك إلاّ أن تبدل الأسماء هنا وهناك، والأماكن هنا وهناك، والملابس والمطاعم هنا وهناك؛ لتعرف إن كان سيبقى من فرق بين الاثنين.
ثم لماذا هؤلاء الشعراء والأمراء وحدهم. لقد كانت مجالس اللهو والخمر والجواري والغلمان منتشرة في كل مكان في ذلك العهد، يشارك فيها مَن نعرف ومَن لا نعرف، وليست حكراً على عصبة المجّان، وكان الأسبق إليها والأقدر عليها هم الخلفاء أُمراء المؤمنين، فهم الذين بدؤوا هذا اللون من الحياة، وهم الذين شجّعوا عليه وأشركوا الشعراء فيه وأغروا به مَن لم يكن يعرفه، وكان أفضل الخمر وأجمل الجواري وأبرع المغنّين من نصيبهم فخزائنهم - بيوت أموال المسلمين - لا تنضب إن كانت خزائن غيرهم معرّضة للنضوب.
لماذا لا نجد بين زنادقة اللهو والمجون اسماً لواحد من هؤلاء الخلفاء، وهم أولى بالزندقة من كل الذين ذكرت أسماؤهم فيها؟ إلاّ إذا كانوا محصنين لا يجري عليهم ما يجري على مَن دونهم ممّن ليسوا خلفاء ولا أمراء للمؤمنين.
لقد ظلموا كثيراً؛ ظلمهم معاصروهم باتهامهم بالزندقة مرةً، وبالشعوبية مرةً، وبالاثنتين مرّات.
وظلمهم الذين كتبوا عنهم بعد قرون، وكانوا أحرى أن ينصفوهم فلم يفعلوا وربّما زاد بعضهم على معاصريهم.
ظلموهم حين جعلوا منهم زنادقة وهو وصف إن صدق على واحد أو اثنين منهم فإنّه لا يصدق عليهم كلهم.
أين هي كتب الزندقة التي ألّفوهّ.
لقد ذكر المؤرّخون ما وضعه الشعوبيون من كتب في مثالب العرب والطعن فيهم وفي مناقب الفرس وتفضيلهم.
فأين هي كتب الزندقة التي ألّفها: والبة، أو مطيع، أو يحيى، أو حماد، أو عمارة بن حمزة، أو حتى زعيم هذه العصبة وأشهر أفرادها أبو نواس؟ ولو ألّفوا، فما أظنهم كانوا سيؤلّفون في المانوية المحرّمة للذات التي أولعوا بها وعاشوا لها، والتي كانت تمثّل أحد أبرز وجوه الزندقة آنذاك.
أهناك أكثر من أبيات هجاء قالها بعضهم في بعض، أو اتهم بها بعضهم بعضاً بالزندقة والمانوية هزلاً وعبثاً يعكسان حياتهم ويمثّلانها خير تمثيل. ولو صدقناهم لصدقنا ما قاله الشعراء العرب في هجاء بعضهم، ولأعطينا الشعوبية الحق في بعض ما يتهمون به العرب.
والآن لا أدري إن كنت قد استطعت ولو إلى حد ما بيان بعض أسباب الخلط في تأريخنا بين الزندقة أو بشكل أدق صورة من صورها وبين الشعوبية.
لعلّي قد فعلت وإلاّ فلن يضير أولئك (الزنادقة) زيادة واحد من الذين لم يحسنوا النظر إليهم ولا الدفاع عن قضيتهم.
تقييم لحركَتَي: الـزندقة والشعوبية
وأخيراً فقد آن لنا أن نضع الزندقة والشعوبية كمصطلحين كان لهما شأن، في إطارهما الصحيح بين الحركات الفكرية والسياسية في تأريخنا دون تعصّب لهما أو عليهما بعد أكثر من ألف عام على اختفائهم.
ولقد رأيت الذين كتبوا عنهما قلّما كتبوا بعمق وحياد. وإذا استثنيت بعضاً منهم: المرحوم أحمد أمين، فأنا لم أجد بين الذين كتبوا من يملك عمق المؤرّخ ولا فهم الأديب ولا حياد العالم وإنّما وضعوا أمامهم الطبري والأغاني، ولا بأس بالنقل عن الجاحظ وابن عبد ربّه، ثم ضمّوا إليهم فان فلوتن فهو اسم غريب قد يوحي للسامع ما لا توحي به أسماء قرأها وسمع عنها.
ومضوا يكتبون، وكان خيراً لهم ألاّ يكتبوا فقد شوهوا تأريخنا - على كثرة ما شوه - وكانوا - لو عرفوا - شعوبيين أكثر من الشعوبيين الذين يهاجمونهم، حين جعلوا من العرب مجموعة من عديمي الإدراك والتمييز، يساقون إلى حيث يراد بهم ويفعلون ما يُخطّط لهم، دون أن يكون لهم من فكرهم ووعيهم ما يمنعهم من إلحاق الأذى بأنفسهم ويحصنهم ضد أعدائهم الذين يتربّصون بهم.
وهم في كل ذلك يكثرون الحديث عن خبث عدوّهم وشدّة كيده، وكأنّهم يحاولون الاعتذار عن العرب.
لقد أرادوا أن تكون لهم كتب في المكتبات يقرؤها القرّاء فكان لهم غباء في المكتبات يواجه القراء، ولو أنصفوا أنفسهم وأنصفونا لاكتفوا بإحالتنا على مَن نقلوا عنهم، فلم يضيفوا إلى أخطاء وقع فيها المؤلّفون قبل ألف عام، أخطاء جديدة بعد ألف عام.
ولقد تحدثت بالتفصيل عن الظروف التي نشأت فيها الزندقة والشعوبية وعن العلاقة بينهما فلا حاجة للعودة إليها.
ولكن أريد أن أقرّر هنا: أنّ الشعوبية كانت ستظهر يوماً ما ولم يكن ممكناً منعها، وهي قانون من قوانين التأريخ وسنّة الأمم قبل وبعد.
لقد كانت هناك أُمّة غالبة معها الإسلام وأمم مغلوبة دخلت فيه كرهاً أو طوعاً، حرباً أو اقتناعاً ورغبة، وكان الفرس أكثر هذه الأمم وأعلاها شأناً في الجاهلية، وهم إحدى إمبراطوريتين كانت لهما السيادة قبل ظهور الإسلام.
ولم يكن الإسلام يفرض على الداخلين فيه أن ينسلخوا عن أجناسهم ويصبحوا أُمّة واحدة بالمفهوم القومي للأُمة كشرط لقبول الإسلام منهم، والقرآن يقول ( وجعلناكم شعوباً وقبائل... ) ويقول: ( ولو شاء الله لجعلكم أُمّة واحدة ) ( ولو شاء ربّك لجعل الناس أُمّة واحدة ) .
وكان التعامل مع هؤلاء المسلمين الجدد يجري في كثير من الرفق خلال عهد الراشدين، ووجود الكثير من ذوي الدين والفضل والسابقة من الصحابة الذين رافقوا النبي وعاشوا معه وتعلّموا منه.
وكان هذا التعامل الرفيق الذي لقيه هؤلاء المسلمون، قد ساعدهم على الاندماج في البيئة الإسلامية العربية والابتعاد عن ماضيهم، إذ لم يكن هناك ما يثيرهم ويدفعهم إلى العودة إليه والتفكير فيه.
شاركوا في فتوح المسلمين وكان لبعضهم دور مذكور فيه، ونافسوا العرب المسلمين في الدين حتى كان بينهم مَن يرجع إليه في أُموره.
وانتهى عهد الراشدين باغتيال الإمام علي عام 40 للهجرة.
وقام حكم جديد انحسر فيه الإسلام وقويت العصبية، وقد ساهمت السياسة الأموية في إذكاء العصبية القبلية بين قبائل العرب، والعصبية القومية بين العرب وبين الأُمم الأخرى. والعرب فخورون بطبعهم يتباهون بأنسابهم وقبائلهم وأسرهم حتى على بعضهم. أي عربي يقبل أن يساوي بين تميم وبكر ومذحج وبين باهلة وغني وسلول.
ولأترك الحديث عن العصبية بين القبائل العربية، على خطورة هذا الموضوع، وأحصره بالعصبية القومية بين العرب وبين الموالي، السبب المباشر لظهور الشعوبية.
كان جيل جديد قد نشأ بين العرب، وجيل آخر جديد قد نشأ من الموالي، وكان الإسلام - الدين والسلوك والجامع للعرب والموالي - قد ضعف لدى أولئك وهؤلاء.
وبدأ المتعصّبون من العرب في تحقير الموالي الذين ازداد عددهم، خصوصاً في العراق، وإشعارهم بالاستعلاء عليهم والاستهانة بهم كما سبق أن ذكرنا.
وسكت الموالي الفرس وتجرّعوا الإهانة ولم يستطيعوا الرد؛ إذ كان الحكم عربياً مستبدّاً طاغياً لا يرحم العرب إذ أحس منهم ما يخشى فكيف بالموالي.
لكن سكوتهم كان سكوت الخوف لا سكوت الرضا، فعادوا إلى ماضيهم وهو غير بعيد يتسلّحون به في رد الهجوم عندما يستطيعون، وإلى ماضي العرب يتسلّحون به في الهجوم عندما يستطيعون، وليس هناك ماض أو تأريخ يخلو من مطاعن لمَن يبحث عنها ويتطلّبها.
وكان هجاء العرب لبعضهم أوّل أسلحتهم، ثم جاءت كتب المثالب التي ألّفها العرب ضد العرب وبدأها زياد بن أبيه سلاحاً ماضياً آخر.
وهكذا وجد الفرس بأيديهم سلاحاً عربياً جاهزاً لمهاجمة العرب والنيل منهم، وطعنهم في أكثر ما يعتزّون به من مناقب، وكان العرب كما ترى هم الشعوبيون الأول عن عمد أو غير عمد.
وضعف سلطان الدولة الأموية في بداية القرن الثاني، ثم سقطت في الثلث الأوّل منه لتقوم الدولة العباسية بمساعدة الفرس ودعمهم وتأييدهم.
وزال الخوف الذي كان يمنع الفرس من الرد أو إعلانه، فبدأ شعراؤهم وكتّابهم في نظم مفاخرهم والكتابة عنها وكانوا قبلاً لا يتناولونها إلاّ نادراً، ولم أجد المؤلّفين يذكرون غير إسماعيل بن يسار مثلاً للشعوبي المجاهر بشعوبيته، الفخور بها في العصر الأموي، وقد دفع ثمنها غالياً فكان ما يزال محروماً مطروداً كما يصفه أبو الفرج.
وكان الصدر الأول من الحكم العباسي ساحة صراع لا سياسي فقط بين العرب والفرس، وإنّما كانت الثقافة والأدب شعراً ونثراً ساحة أخرى للصراع بينهم.
لكن الصراع كان مكشوفاً هذه المرّة لا يستره خوف كما هي الحال في العصر الأموي.
وبدأ الشعراء وبدأ الكتّاب الفرس ينظمون ويؤلّفون، ولو وقفوا عند ذكر مآثر الفرس وماضيهم وما كان لهم من سلطان وفكر وفن لما أنكر عليهم أحد. ولقيل قوم ظلموا فثأروا لأنفسهم ودفعوا الظلم وردوا الاتهام، ولكنّهم أفادوا من تلك الفترة التي كانت فيها السلطة الجديدة تراعي الفرس وتترضّاهم وتتجنب سخطهم، فجاوزوا الدفاع إلى الهجوم. ونظم بشّار وكتب أبو عبيدة وكتب علان وكتب غيرهم، لا في مآثر الفرس ولكن في مثالب العرب. حاولوا أن يجرّدوهم من كل فضائلهم بل أن يقلبوا فضائلهم عيوباً. وكان من هؤلاء مَن يجد الدعم والحماية في أسر فارسية ذات سلطة ونفوذ آنذاك كآل طاهر وغيرهم.
وألاحظ أنّ هذه الزندقة والشعوبية الأدبية القائمة على الشعراء والكتّاب والمفاخر والمثالب لم تتجاوز كثيراً حدود العراق، حيث الاحتكاك في ذلك الوقت بين العرب وبين الفرس، وحيث تواجهت لأوّل مرة حضارتان بكل ما تحملان من قيم وعادات وأسلوب في الحياة جديد.
على أنّ من الأمانة أن أضيف: أنّ هاتين الظاهرتين قد ضعفتا كثيراً مع منتصف القرن الثالث الهجري، بعد أن هدأت النفوس وتراجعت حدة العواطف، وأصبح هذا الأسلوب الجديد في الحياة أسلوباً عراقياً قبله العرب وقبله الفرس، ولم يعد سبباً للنزاع بينهما ولم تعد تسمع للزندقة الأدبية ولا للشعوبية الأدبية صوت.
ثم حصل تطوّر خطير آخر غيّر من اتجاه الصراع وشغل العرب عن الفرس، وشغل الفرس عن العرب. فقد دخلت الساحة أمم وأقوام أخرى كالترك والديلم والمغاربة، وتحوّل الصراع إلى صراع بين هذه الأمم والأقوام نفسها ومن بينها الفرس. والى صراع بين زعمائها والبارزين فيها، لكنّه صراع على السلطة والنفوذ في ظل حكم ضعيف.
وتخلّت الشعوبية الأدبية عن مكانها إلى شعوبية سياسية لم يعد العرب والفرس طرفيها، ولا أبو معاذ وأبو عبيدة من قادتها بل شارك فيه، وكان من أطرافها الأمم والأقوام الأخرى، واستبدل فيها ببشّار ومعمر أوزون ونازوك ومؤنس.
وخلال ذلك شهد العراق، وفي القسم الأوسط والجنوبي منه، حركات قوية لها طبيعة اجتماعية واقتصادية بعيدة عن الشعر والأدب والمفاخر والمثالب: كثورة الزنج، وحركات القرامطة.
هذا في العراق الذي حاولت أن أحصر حديثي عن الزندقة والشعوبية فيه، كما هي في جانبهما الأدبي الذي عرفتا به.
أمّا في أطراف الدولة العربية الإسلامية فقد قامت في الجانب الشرقي منها دويلات غير عربية: فارسية أو تركية. احتفظت مع فارسيتها أو تركيتها بدينها الإسلامي، فهي فارسية مسلمة أو تركية مسلمة لم تعرف حركة اسمها الشعوبية، كما عرفها العراق في العصر الذي تحدثت عنه؛ لأسباب منها: أنّ تلك الدويلات قامت على أراضيها بعيداً عن مركز الدولة العربية الإسلامية في العراق، وكان بعدها هذا مانعاً للاحتكاك الذي رأيناه بين العرب والفرس في العراق وما ولّده من كره وكره مقابل. ومنها: أنّ تلك الدويلات لم يكن لها ماض يوازي، أو يقارب ما كان للفرس من ماض، عندما كانت الإمبراطورية الفارسية إحدى أقوى إمبراطوريتين في العالم، فهي لا تستطيع أن تقابل العرب بما يستطيع الفرس أن يقابلوا به العرب. ومنها أنّ الدولة العربية الإسلامية كانت قد بلغت درجة من الضعف لا تسمح لها بمواجهة ما يجري في العراق نفسه إلاّ بجهد وصعوبة، ناهيك عن مواجهة دويلات منظمة لها جيوش تستطيع القتال وهي في أراضيها على ألوف الكيلو مترات من بغداد. وإذا كانت ثورتا المقنع وبابك الشعوبيتان قد فشلتا؛ فذلك لأنّهما قامتا والدولة المركزية ما تزال قوية بعد، تملك أن تواجه وأن تنتصر؛ ولأنّ الثورتين قد أسقطتا الإسلام وقامتا على أساس قومي فارسي بعيد عن الإسلام، فحاربهما العرب لفارسيتهم، وحاربهما المسلمون غير العرب لابتعادهما عن الإسلام. بقي أن نلاحظ أنّه حتى في العصر العباسي الذي كان نفوذ الفرس هو المسيطر والطاغي، كان النسب العربي ساحراً جذّاباً يتعلّق به من لا يمنعه وضوح نسبه غير العربي من التعلّق به والانتماء إليه. وهذا ما نراه واضحاً في هجاء بعض الموالي الذين تركوا نسبهم الأصلي واستبدلوا به نسباً عربياً. بل هذا ما نجده في هجاء بعض العرب من المغموزين في نسبهم فأشجع السلمي، يريد شاعر أن يهجوه فلا يجد لذلك منفذاً إلاّ عن طريق نسبه فيقول:
إنّما أنت من سليم كواو |
ألحقت في الهجاء ظلماً بعمرو |
والهيثم بن عدي الطائي يهجوه أبو نواس، وهو الذي يسخر من تميم وقيس والعرب كلهم فيقول فيه:
إذا نسبت عدياً في بني ثعل |
فقدّم الدال قبل العين في النسبِ |
وحتى أبو عمرو بن العلاء يغضب بشّار على ابنه خلف فيقول:
أرفق بعمرو إذا حرّكت نسبته |
فإنّه عربي من قوارير |
والأمثلة على ذلك كثيرة.
وما أظن النسب العربي كان يحظى بكل هذا الاهتمام من جانب المنتسب أو من جانب النافي له، لو لم يكن له شأن وحساب ولو لم يكن موضع اعتزاز وفخر في ذلك الوقت.
والآن أعود بعد هذه الرحلة الطويلة لأؤكّد ما سبق أن قلته عن الشعوبية في بداية الحديث: من أنّها كانت ستظهر يوماً ما دامت هناك أُمّة غالبة حاكمة وأُمّة وأمم مغلوبة محكومة. فهذا أول أسباب الصراع حتى لو تخلّفت الأسباب الأخرى، ولا بد لهذا الصراع أن ينفجر ثورة عندما تتوفّر ظروف نجاحها، وأحياناً حتى لو لم تتوفّر ظروف نجاحها.
لقد بقي العرب زهاء سبعة قرون تحت الحكم العثماني المسلم، لكن لا طول المدة ولا إسلام العثمانيين أنسيا العرب عروبتهم ومنعهم من المطالبة الدائمة باستقلالهم الذي حصلوا عليه عبر ثورات ودماء وشهداء.
وهذا الاتحاد السوفيتي، ما أسرع ما رجعت كل قومية من قومياتها إلى ذاتها تبني دولتها الخاصة بها، بالرغم ممّا كان يربطها خلال سبعين عاماً من نظام اقتصادي وسياسي واحد.
وحتى يوغوسلافيا، هذا البلد الصغير، لم يسلم من التمزّق وانقسامه إلى دول بعدد القوميات التي كان يتألّف منها.
وأظنني بعد هذا استغرب ممّن يستغرب حركة الشعوبية وكأنّها حركة خارج التأريخ.
الفهرس
المقدّمة: 2
الإهداء: 3
القسم الأوّل: فـي الزندقة 4
الفصـل الأوّل: مفهوم الزندقة عند المسلمين .5
الفصـل ا لثاني: الزندقـة في الجاهليـة 10
1 - الزندقة وقريش: 10
2 - المجوسيّة في تميم: 16
الفصل الثا لث: الزندقـة فـي الإسلام 20
الفصـل ال رابع: المجوسيّة 25
الفصل ال خامس: المانويّـة 26
الفصـل ا لسـاد س: المزدكيّـة 27
الفصـل السـا بع: البـرامكـة 32
الفصل ال ث ا من: آل سهل .43
الفصل ال ت ا س ـ ع: عبد الله بن أبي عبيد الله .46
الفصل ال ع ا ش ـ ر: عبد الله بن المقفّع .49
الفصـل ال ح ا دي عشـر: صالح بن عبد القدوس .56
الفصـل ال ث ا ن ي عشـر: عبد الكريم بن أبي العوجاء 59
الفصـل الثا لث عشـر: بشّار بن بُـرْد 63
القسـم الثانـي: الشعوبيّة 75
القسم الثالـث: العـلاقـة بين الزندقة وبين الشعـوبية 98
تقييم لحركَتَي: الـزندقة والشعوبية 106