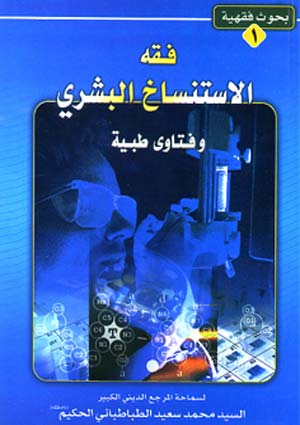فقه الاستنساخ البشري
وفتاوى طبّيّة
لسماحة المرجع الديني الكبير
السيّد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم (دام ظلّه)
بسم الله الرحمن الرحيم
وله الحمد، والصلاة والسلام على سيّد الخلق وأشرفهم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
وبعد.. فقد كُتب لهذه الأوراق أن تُنشر عدّة مرّات، ولكن بعد أن يضاف إليها في كل مرّة، وكان بادئ ذلك الاستفتاء الموجّه، من بعض الأُخوة المؤمنين في بريطانيا، إلى سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (دام ظلّه) في بدء الضجّة، بعد الإنجاز العلمي الكبير بإمكان استنساخ الخليّة وما يفترض أن يترتّب على ذلك من إمكان استنساخ الكائن البشري، ثم أُضيف إلى ذلك مجموعة من الأسئلة الشرعية المتعلّقة بذلك الكائن المستنسخ من حيث النسب والميراث، ونحو ذلك.
ثم أُضيف بعض الأسئلة المتعلّقة بالتلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب، ثم بعض الاستفتاءات المتعلّقة ببعض الأُمور الطبّيّة من ما ينفع الطالب والأُستاذ والطبيب والمريض.
ولمّا أن تقرّر إعادة طبعه كانت هناك مواضيع أُخرى صالحة
للنشر، منها: أحكام ترقيع الأعضاء، وأحكام مرض الإيدز، ومنها الحجامة تلك السُّنّة النبوية التي كثر التأكيد عليها في أحاديث الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وعترته الطاهرة، والدعوة إلى الاستطباب بها والإرشاد إلى آثارها ومنافعها. فقد وردت مجموعة من الأسئلة المتعلّقة بها من أحد المراكز الطبّيّة المتخصصة بها، بعد أن طُرحت في المجاميع العلمية الطبيّة كأحد الطرق المعتبرة في مقام العلاج.
وكان لسماحة السيد (دام ظلّه) إجابات وافية عن أحكامها، والدعوة إلى إحيائها، وفتح أبواب المعرفة الحديثة فيها، وفي بقيّة السنن والإرشادات التي تضمّنتها الأحاديث الشريفة.
فهذه المجموعة التي بين يديك، تحوي كل هذا ونحوه من ما يتعلّق بالأُمور الطبيّة. نسأل الله تعالى أن ينفع به القرّاء ويوفّقهم وإيّانا لما فيه الهدى والرشاد، إنّه أرحم الراحمين.
الناشر
الاستنساخ البشري
تقديم بقلم: د. أبو حسين المصري
بسم الله الرحمن الرحيم
( سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ )
إنّ مسألة البحث والتطوّر العلمي من لوازم وجود الإنسان فوق هذا الكوكب؛ لأنّه الطبيعة الناطقة والتي تقوّم الإنسان وتميّزه عن غيره من الحيوانات هي مبدأ التفكير الذي يُعدّ الأساس لاكتشاف كل مجهول في هذا الكون، وبالتالي الانطلاق في آفاق التقدّم العلمي.
وعلى الرغم من استحالة الوقوف في وجه هذه الخصيصة الإنسانية، أو عرقلة عجلة التقدّم والتطوير العلمي للإنسان، لكن لابدّ من وجود قانون أخلاقي يكون ناظراً وحاكياً ومشرفاً على نتائج هذه الحركة العلمية، من أجل حفظه من الانحراف أو الطغيان المنافي للكمال الحقيقي للإنسان في هذا العالم.
وليس لدينا أفضل ولا أكمل من الشريعة الإسلامية
الغرّاء، والتي لها في كل واقعة حكم لترشيد وهداية هذه الحركة العلمية، واستثمار نتائجها لصالح البشرية.
وعلى الرغم من أنّه لا يوجد من الأديان قد حثّ أتباعه على طلب العلم والمعرفة في كل مكان مثل الدين الإسلامي الحنيف، إلاّ أنّه في الوقت ذاته حثّهم على أن يشكروا هذه النعمة الكبيرة أي العقل والعلم، وأن يسخّروا علومهم لخدمة الإنسانية جمعاء، وألاّ يكفروا هذه النعمة بتسخيرها في خدمة الشرّ، وهلاك البشرية كما يحدث في كثير من الأحيان في الغرب في زماننا الحاضر.
والإنسان المؤمن بما يتحلّى به من الرؤيا الكونية يرى أنّ الدنيا وسيلة إلى الآخرة، فهو حريص أن يعرف موقف الدين الإسلامي الحنيف من كل حادثة في زمانه، فيفزع إلى أهل الذكر وهم فقهاء الإسلام ( رضي الله عنه ) من أجل معرفة الحكم الشرعي وتعميم تكليفه تجاه ذلك الأمر.
ومن هذه الحوادث ظهر في الغرب في عام ( ١٩٩٧م ) اكتشاف علمي كبير وعجيب قائم على أساس الاستنساخ الحيواني أي الحصول على نسخة طبق الأصل من الحيوان الموجود - كما سيأتي تفصيله - وقد تمّت التجربة بنجاح في بريطانيا باستنساخ نعجة سُمّيت ( دولي ) ممّا أثار ضجّة
عالمية كبيرة وأوجدت ردود أفعال متباينة بين موافق ومخالف خاصة مع إمكان تطبيقها على الإنسان.
وقبل الولوج في بيان كيفية هذه العملية لابد من تقديم مقدمة مختصرة عن طبيعة الخليّة الحيوانية، والتي يشترك فيها الإنسان مع سائر الحيوانات، وعن كيفية تكاثرها الطبيعي والجنسي.
١- تركيب الخليّة الحيوانية:
تتركّب الخليّة الحيوانية من نواة مركزية تُعدّ مبدأ الفاعلية الحيوية فيها، وتحتوي على ( ٤٦ ) من الأجسام الصبغية ( الكروموسومات ) الحاملة للعوامل الوراثية ( الجينات )، وهي محاطة بغشاء رقيق ويحيط بها من الخارج سائل غذائي مخصوص يسمّى ( سيتوبلازم ) المحاط بدوره بغشاء الخليّة نفسها.
٢ - أنواع التكاثر الخلوي:
أ - التكاثر الطبيعي: وهو الذي يتمّ في جميع أعضاء الجسم الطبيعية ويؤدّي إلى نموّها، وفيها ينشطر كل جسم من الأجسام الصبغية إلى نصفين، ثم يكمل كل نصف نفسه إلى جسم كامل، ويذهب كل شطر بعد تكامله إلى أطراف النواة
والتي تنقسم بعد ذلك إلى نواتين، ثم تنقسم الخليّة بعد ذلك إلى قسمين، يحتوي كل قسم منها على نواة مستقلّة تحمل نفس عدد الأجسام الصبغية ( ٤٦ ) التي كانت موجودة في الخليّة الأُولى.
ب - التكاثر الجنسي: ويتم داخل الأعضاء الجنسية لكل إنسان أي الخصيتين في الذكر، والمبيضين في الأُنثى، حيث تنقسم الخليّة في هذه الأعضاء بنحو آخر؛ وذلك بانقسام الأجسام الصبغية فيها إلى نصفين كما هو الحال في التكاثر الطبيعي، ولكنّه يبقى كل نصف على حاله لا يتكامل، ثم تنقسم النواة والخلية بعد ذلك إلى خليّتين جنسيّتين، وهما الحيامن في الذكر والبويضات في الأُنثى.
وتحتوي كل خليّة جنسية على نواة تحمل ( ٢٣ ) كروموسوم أي نصف عدد الكروموسومات في الخليّة الطبيعية، ومن أجل الحصول بعد ذلك على الجنين الحيواني أو الإنساني هناك طريقان:
١ - الطريق الطبيعي: وذلك بإيصال الحيامن الذكرية إلى رحم الأُنثى عن طريق الجماع الجنسي الطبيعي، وهناك تلتقي الحيامن مع البويضة، ويتمكّن واحد منها - بإذن الله تعالى - من تلقيح البويضة فتنعقد النطفة وتتعلّق بالرحم ثم
تصير علقة ومضغة وتستكمل بعد ذلك جنيناً تاماً.
٢ - الطريق الصناعي: وهو طريق مستحدث منذ عدّة سنوات لمعالجة حالات العقم ويتم عن طريق أخذ الحيامن الذكرية والبويضات وتلقيحها خارج الرحم في أنبوبة تحتوي على محيط غذائي خاص، ثم بعد انعقاد النطفة يتمّ إعادة حقنها في الرحم لتستكمل جنيناً بعد ذلك.
والجدير بالإشارة هنا أنّه في كلا الحالتين فإنّه بعد التلقيح تتحد نواة الحيوان المنوي الذكري مع نواة البويضة الأُنثوية والذي يحتوي كلاًّ منها على ( ٢٣ ) كروموسوم ليصيرا نواة واحدة تحتوي على ( ٤٦ ) كروموسوم، تحوي الصفات الوراثية المشتركة بين الذكر والأُنثى، ثم تبدأ النواة المشتركة بعد ذلك في التكاثر والانقسام في طريق حصول الجنين.
ومن الواضح هنا أنّ الجنين الحاصل ليس نسخة طبق الأصل من الذكر أو الأُنثى، بل هو حصيلة إنتاج مشتركة بينهما يحمل صفاتها الوراثية، فهو ابن لهما.
وبعد الانتهاء من هذه المقدمة التمهيدية نشرع في بيان مختصر عن عملية الاستنساخ الحيواني والتي هي موضوع بحثنا:
تبدأ هذه العملية بانتزاع خليّة جسمية لا جنسية من
جسم الحيوان المطلوب استنساخه سواء كان ذكر أو أنثى ( وفي مورد النعجة المذكورة تمّ أخذها من الضرع ) ثم يتم بعد ذلك تفريغ الخلية من نواتها المشتملة بالطبع على ( ٤٦ ) كروموسوم، ثم بعد ذلك يتم وضع هذه النواة في بويضة أُنثوية بعد تفريغها من نواتها الخاصة بها والتي كانت تشتمل على ( ٢٣ ) كروموسوم، وذلك في محيط غذائي خارج الرحم في المختبر، وبالتالي يصبح لدينا خليّة نواتها من حيوان يحمل جميع صفاته الوراثية بعينها، ومحيطها الغذائي ( السيتوبلازم ) من حيوان آخر وبما أنّ السائل السيتوبلازمي هو الذي يحدّد مسير انقسام النواة، فسوف تبدأ النواة الضيفة بعد التحفيز الصناعي بالانقسام في اتجاه تكوين الجنين فتصبح بحكم النطفة، ثم يعاد حقن هذه النطفة المنقسمة إلى رحم أُنثى حيوان حتى يستكمل هناك جنيناً تامّاً يكون نسخة طبق الأصل من الحيوان صاحب النواة يحمل جميع صفاته الوراثية.
رفع شبهة: إنّ هذه العملية ليست من باب الخلق ولا الإيجاد المختصة بالله تعالى، ولكنّه عبارة عن عملية تلقيح صناعي معدّل، تنقل فيها النواة التي تحتوي على سر الحياة إلى البويضة، ثم إعادتها بعد التلقيح إلى الرحم من أُخرى ليحصل الجنين بعد ذلك بالطريق الطبيعي.
أصل الإشكال: إنّ الإشكال المهم في هذه العملية، والذي كان مثار ضجّة كبيرة، وحيرة بين الناس خاصة المؤمنين منهم، هو أنّ الجنين الحاصل من هذه العملية ليس في الحقيقة إنتاجاً مشتركاً بين الذكر والأُنثى، كما بيّنّا سابقاً؛ لأنّه ليس نتيجة تلاقح بين نواة الحيوان المنوي للذكر ونواة البويضة للأُنثى، بل عبارة عن تكثير نواة واحدة لطرف واحد بالاستعانة بمحيط غذائي ( سيتوبلازم ) لبويضة حيوان آخر، وبالتالي لا يحمل إلاّ الصفات الوراثية لطرف واحد وهو صاحب النواة، وبالتالي ينتفي المعنى العرفي للبنوّة لكل من الأب والأم.
وبما أنّ الأحكام تابعة للعناوين، فنقع في مشكلة كبيرة متعلّقة بأحكام النسب والمواريث لهذا الجنين الحاصل، وما يتفرّع عليها من أحكام كثيرة في باب المعاملات كالنكاح بالولاية وغيرها.
وعلى الرغم من أنّ هذه العملية لم تطبّق بعد على الإنسان إلاّ أنّ إمكانها موجود، ومن أجل الاستعداد لمثل هذا الاحتمال فقد لاذ المسلمون إلى علمائهم يستفتونهم عن رأي الدين والشريعة في أصل شرعيّة هذه العملية، والموقف الشرعي في هذا الطفل الحاصل من هذه العملية، والذي يُعدّ نسخة طبق الأصل من صاحب النواة.
وكان في مقدمة هؤلاء العلماء الأعلام سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم ( أدام الله ظلّه الشريف على رؤوس المسلمين ) فقد تصدّى سماحته للإجابة عن بعض الأسئلة المطروحة من جانب بعض المؤمنين، وتفضّل ببيان الحكم الشرعي فيها.
وفي الختام نسأل المولى عزّ وجلّ أن يحفظ سماحته ويوفّقه لخدمة الشريعة الغرّاء، وأن ينفعنا بعلمه الشريف في الدنيا والآخرة.
والحمد لله ربّ العالمين.
د. أبو حسين المصري
بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظلّه)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
يرجى الإجابة على الأسئلة التالية، ولكم من الله جزيل الأجر ومنّا كثير الشكر سلفاً:
وذلك أنّه بعد كثير من التجارب العلمية واستخدام أحدث التقنيات، اكتشفت طريقة جديدة لإنتاج الكائنات الحيّة.
فقد أعلن العلماء أنّ من الممكن تطبيقها على الإنسان - بعد نجاح عمليّاتها على الحيوان والنبات - وقد سُمّيت هذه العملية بـ ( الاستنساخ الجيني ).
وتتم بأخذ بويضة أُنثوية، وبعد تفريغ البويضة من نواتها تؤخذ خلية جسم عادية وتؤخذ منها نواتها، ثم تزرق نواة الخليّة العادية داخل البويضة المفرغة، وبتأثير شرارة كهربائية تبدأ بالانقسام مكوّنة كائناً جديداً، ثم توضع
البويضة - بعد تبديل نواتها - داخل رحم الأُنثى لتبدأ مسيرتها فيه كجنين.
ومن سمات الكائن الجديد كونه مطابقاً تماماً للكائن صاحب الخلية، وأنّه لا يحتاج لذكر وأُنثى لتكوينه، ولا يحتاج إلاّ إلى الأُنثى فقط، ممّا يؤدّي لأن تكون عمليات تكوين الإنسان خارج نطاق الأُسرة.
وسُمّيت هذه العملية بالاستنساخ؛ لأنّه لا يمكن تمييز الكائن الجديد عن القديم إطلاقاً، ويقال: إنّ هذه العملية ستسبّب مشاكل أخلاقية كبيرة، إذ من الممكن أن يستخدمها المجرمون للهروب من العدالة، كأن تكون هناك نسختان متطابقتان تماماً تقوم إحداهما بجريمة ولا يمكن معرفة الفاعل الحقيقي.
وقد تمّ فعلاً إنتاج نعجة وفق هذه الطريقة بعد ( ٢٢٧ ) محاولة فاشلة.
فما هو موقف الشرع المقدّس من خلال هذه الأسئلة التي نعرضها على سماحتكم
( أوّلاً ): عن جواز أصل العملية أو عدمه شرعاً لو تمّ تخليق إنسان بهذه الطريقة؟ وبأيّة شروط لو كانت؟
( ثانياً ): إذا كان من خلق بهذه الطريقة - إنساناً - فما
هو نسبته للشخص الذي انتزعت منه الخلية، امرأة كان أو رجلاً.
أ - هل هو بمنزلة الابن، بالنظر إلى أنّ أصل تخليقه هو الخلية المأخوذة عنه بدلاً من الحويمن أو البويضة في التولّد الاعتيادي.
ب - أم بمنزلة الأخ؛ لأنّ انتسابه بايولوجياً ووراثياً لخلية كان ما فيها من موروثات هو حاصل جمع حويمن وبويضة والدي صاحب الخلية.
ج - أم هو أجنبي شرعاً؟ وكيف نصنع بالانتساب البايولوجي والوراثي لصاحب الخلية، أعني: أنّه من هذه الناحية علمياً يعتبر قرابة له، شأنه شأن المخلوق بالطريقة الاعتيادية.
( ثالثاً ): ما هو حكمه من حيث تبعيّته الدينية أثناء الطفولة، هل يعتبر مسلماً أم كافراً؟ أم تكون نسبته طبقاً لدين صاحب الخلية؟
( رابعاً ): ما حكمه من حيث النسب:
- فيما يتصل بالعاقلة أو لولاء ضامن الجريرة؟
ب - هل يعتبر هاشمياً لو أُخذت الخلية من هاشمي، حتى مع الحكم بعدم بنوّته أو أُخوّته لصاحب الخلية؟
( خامساً ): هل هناك حقوق تترتّب شرعاً بينه وبين
صاحب الخلية؟
( سادساً ): لو اعتبر بمنزلة الأجنبي، فما هو حكمه من حيث جواز زواجه ممّن لو كان ابناً أو أخاً لصاحب الخلية لكان من المحرّمات بالنسبة له؟
( سابعاً ): ما هو حكم الحيوان المخلوق بهذه الطريقة من حيث عائديّته أو ملكيته، هل يعود لمالك الحيوان الذي انتزعت منه البويضة أو الخلية؟ أم هو للقائم بعملية التخليق؟
( ثامناً ): ما هو حكم لحم ولبن الحيوان الذي تصرّفوا في هندسته الوراثية حتى أصبح دمه مشابهاً لدم الإنسان؟ وما هو حكم الدم المتخلّف من هذا الحيوان لو ذُكّي؟
( تاسعاً ): يجري الحديث عن إمكانية استنساخ بعض أعضاء الإنسان في المختبر وحفظها كاحتياطي له، أو لأي شخص آخر عند الحاجة إليها، فهل يجوز ذلك؟ وهل يشمل الجواز الأعضاء التناسلية، أو لا يجوز باعتبار أنّها منسوبة للشخص فيحرم كشفها مثلاً؟ وكذلك بالنسبة لاستنساخ الدماغ هل هو جائز؟ علماً أنّه هناك دراسة عملية حول الموضوع، يراد بحث الجانب الفقهي فيه.
الرجاء سيّدنا الفقيه الأجل ( دام ظلّكم ) الإجابة على هذه الأسئلة بتفصيل؛ لأنّها أسئلة تدور بين المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم
ج: الظاهر إباحة إنتاج الكائن الحي بهذه الطريقة أو غيرها ممّا يرجع إلى استخدام نواميس الكون التي أودعها الله تعالى فيه، والتي يكون في استكشافها المزيد من معرفة آيات الله تعالى وعظيم قدرته ودقّة صنعته، استزادة في تثبيت الحجّة وتنبيهاً على صدق الدعوة، كما قال عزّ من قائل:( سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ) .
ولا يحرم من ذلك إلاّ ما كان عن طريق الزنا، ويلحق به على الأحوط وجوباً تلقيح بويضة المرأة بحيمن الرجل الأجنبي تلقيحاً صناعياً خارج الرحم، بحيث ينتسب الكائن الحي لأبوين أجنبيين ليس بينهما سبب محلل للنكاح. أمّا ما عدا ذلك فلا يحرم في نفسه، إلاّ أن يقارن أمراً محرّماً كالنظر لما يحرم النظر إليه ولمس ما يحرم لمسه، فيحرم ذلك الأمر.
وقد سبق أن وَرَدنا استفتاء حول هذا الموضوع من بعض الأُخوة، الذين يعيشون في بريطانيا عند قيام الضجّة الإعلامية العالمية
حوله بين مؤيّد ومعارض، وقد أشير فيه لبعض الأُمور التي سيقت كمحاذير يتوهّم منها التحريم، وهي:
١ - إنتاج الكائن الحي خارج نطاق الأُسرة.
ولم يتضح الوجه في التحريم من أجل ذلك، حيث لا دليل في الشريعة على حصر مسار الإنسان في تكوّنه ونشاطاته بسلوك الطرق الطبيعية المألوفة، بل رقي الإنسان إنّما هو باستحداث الطرق الأُخرى، واستخدام نواميس الكون المودعة فيه، التي يطلعه الله عليها بالبحث والاجتهاد، والاستزادة في طرق المعرفة، كما لا دليل على حصر إنتاج الإنسان في ضمن نطاق الأُسرة، ولاسيّما بعد خلق الإنسان الأول من طين، ثم خلق نبي الله عيسى (عليه السلام) من غير أب، وخلق ناقة صالح (عليه السلام) وفصيلها على نحو ذلك، كما تضمّنته الروايات.
٢- إنّ هذه العملية ستسبّب مشاكل أخلاقية كبيرة، إذ من الممكن أن يستخدمها المجرمون للهروب من العدالة.
وهذا كسابقه لا يقتضي التحريم، فإنّ الإجرام وإن كان محرّماً إلاّ أنّ فعل ما قد يستغلّه المجرم ليس محرّماً، وما أكثر ما يقوم العالم اليوم بإنتاج وسائل يستخدمها المجرمون وتنفعهم أكثر ممّا تنفعهم
هذه العملية، ولم يخطر ببال أحد تحريمها. وربّما كان انتفاع المجرمين بمثل عملية التجميل أكثر من انتفاعهم بهذه العملية، فهل تحرم عملية التجميل لذلك؟! وفي الحقيقة أن ترتّب النتائج الحسنة أو السيّئة على مستجدّات الحضارة المعاصرة، تابع للمجتمع الذي تعيش فيه، ويستغلّها، فإذا كان مجتمعاً مثالياً كانت النتائج إنسانية مثمرة، وإذا كان مجتمعاً مادّياً حيوانياً كانت النتائج إجرامية مريعة، كما نلمسه اليوم في نتائج كثير من هذه المستجدّات في المجتمعات المتحضّرة المعاصرة.
٣ - إنّ نجاح هذه العملية قد تسبقه تجارب فاشلة تفسد فيها البويضة قبل أن تنتج الكائن الحي المطلوب.
فإن كان المراد بذلك أنّ إنتاج الكائن الحي لمّا كان معرّضاً للفشل كان محرّماً؛ لأنّه يستتبع قتل البويضة المهيّأة لها وهو محرّم كإسقاط الجنين. فالجواب:
أنّ المحرّم عملية قتل الكائن الحي المحترم الدم، أو قتل البويضة الملقّحة التي هي في الطريق إلى الحياة، وذلك بمثل الإسقاط، وليس المحرّم على المكلّف عملية إنتاج كائن حي يموت قبل أن يستكمل شروط الحياة، من دون أن يكون له يد في موته، فيجوز للإنسان أن يتصل بزوجته جنسياً إذا كانت مهيّأة للحمل، وإن كان الحمل معرّضاً للسقوط نتيجة عدم استكمال شروط الحياة له، بسبب
قصور الحيمن، أو البويضة، أو عدم تهيّؤ الظرف المناسب لاستكمال الجنين نموّه وكسبه للحياة، وعلى كل حال لا نرى مانعاً من العملية المذكورة، إلاّ أن تتوقّف على محرّم آخر، كالنظر لما يحرم النظر إليه ولمس ما يحرم لمسه وغير ذلك.
( ثانياً ): إذا كان مَن خلق بهذه الطريقة - إنساناً - فما هو نسبته للشخص الذي انتزعت منه الخلية، امرأة كان أو رجلاً
ج: إذا كان إنتاجه بالوجه السابق فليس له أب قطعاً؛ لأنّ النسبة للأب تابعة عرفاً لتكوّن الكائن الحي من حيمنه بعد اتحاده مع البويضة، كما يشير إليه قوله تعالى:( ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلالَةٍ من مَّاءٍ مهِينٍ ) . ولا دخل للحيمن هنا بل للخلية المأخوذة من الجسد. وخصوصاً إذا كانت الخلية مأخوذة من جسد المرأة، حيث لا معنى لكونها أباً للإنسان المذكور.
وقد ورد في نصوص كثيرة: أنّ الله تعالى خلق حواء من ضلع آدم، وبغضّ النظر عن صحّة النصوص المذكورة والبناء على مضمونها، فإنّه لم يتوهّم أحد أنّ مقتضى هذه النصوص كون حواء بنتاً لآدم، وذلك يكشف عن أنّ معيار بنوّة شخص لآخر ليس هو خلقته من جزء منه، بل خلقته من مَنِيِّه كما ذكرنا.
وأمّا النسبة للأُم فهي تابعة لتكون الكائن الحي من بويضتها، وهو هنا لا يتكوّن من تمام بويضتها، بل من بعضها بعد تفريغها من نواتها، ومن ثمّ يشكّل نسبته لها. نعم يصعب الجزم بعدمه.
كما لا مجال للبناء على أنّه أخ لصاحب الخلية أو البويضة، بعد أن كان الأخ هو الذي يشارك أخاه في أحد الأبوين، وليس المعيار حمل الخصائص الحياتية والوراثية لعدم دخله في الانتساب عرفاً.
والمرجع في ضابط الانتساب هو العرف لا غير، وعليه عوّل الشارع الأقدس في ترتيب الأحكام حسبما نستفيده من الأدلة الشرعية. ولنفترض أنّ توصّل العلم الحديث إلى اكتشاف ناموس يتيسّر به تحويل خلية حيوانية، أو نباتية، ببعض التعديلات إلى إنسان مشابه لإنسان مخلوق بالطريق الاعتيادي في الخصائص الحياتية والوراثية، فهل يمكن أن نحكم بحصول علاقة نسبية بينهما بمجرّد ذلك، من دون تحقّق الضوابط النسبية العرفية المعهودة؟! لا ريب في عدم جواز ذلك، بل نحن ملزمون بتخطّي التشابه المذكور وتجاهله، والحكم بأنّهما أجنبيان، وهكذا الحال في المقام حيث يتعيّن كون الإنسان المذكور أجنبياً عن صاحب الخلية، وليس بينهما أيّ ارتباط أو عنوان نسبي.
( ثالثاً ): ما هو حكمه من حيث تبعيّته الدينية أثناء الطفولة، هل يعتبر مسلماً
أم كافراً؟ أم يكون نسبته طبقاً لدين صاحب الخلية؟
ج: مادام طفلاً لا تمييز له يجري عليه حكم مَن هو تابع له في حياته، بحيث يصير في حوزته، كما يتبع الطفل الأسير آسره، فإذا صار مميّزاً فهو محكوم بحكم الدين الذي يعتنقه، ولو فرض كفره لم يكن مرتدّاً حتى لو كان صاحب الخلية مسلماً؛ لعدم كونه أباً له كما سبق.
( رابعاً ): ما حكمه من حيث النسب؟
ج: لمّا كان الانتساب للعشيرة يتفرّع على الانتساب للأب، فعدم انتساب الإنسان المذكور لصاحب الخلية بالبنوّة وعدم أبوّة صاحب الخلية له - كما سبق - يستلزم عدم انتسابه لعشيرة صاحب الخلية، وعدم كونه هاشمياً لو كان صاحب الخلية هاشمياً مثلاً، كما يتضح بملاحظة ما تقدّم في جواب السؤال الثاني، وعلى ذلك ليس له عاقلة بل ينحصر عقله بضامن الجريرة والإمام (عليه السلام).
نعم حيث تقدّم الشك في انتسابه لصاحبة البويضة، يتعيّن الشك في انتسابه لمَن ينتسب إليها، مثل كونه سبطاً لأبويها وكون أخوتها أخوالاً له، ولا طريق للجزم بثبوت الانتساب المذكور ولا نفيه، ولا بثبوت آثاره ولا نفيها، بل يتعيّن الاحتياط في ترتيب الأحكام الشرعية المتعلّقة بذلك.
( خامساً ): هل هناك حقوق تترتّب شرعاً بينه وبين صاحب الخلية؟
ج: لا حقوق بينهما لعدم النسبة بينهما، على ما تقدّم في جواب السؤال الثاني.
( سادساً ): لو اعتبر بمنزلة الأجنبي، فما هو حكمه من حيث جواز زواجه ممّن لو كان ابناً أو أخاً لصاحب الخلية لكان من المحرّمات بالنسبة له؟
ج: مقتضى ما تقدم عدم المحرّمية بين الإنسان المذكور وصاحب الخلية، فضلاً عمّن يتصل به كأبيه وأخيه وابنه.
نعم قد يظهر من بعض النصوص الواردة في بدء التكوين استنكار نكاح الإنسان لما يتكوّن من بعضه، والنص المذكور وإن كان ضعيفاً سنداً إلاّ أنّ المرتكزات الشرعية قد تؤيّده، من دون أن تنهض حجّة قاطعة تسوّغ الفتوى بالتحريم، ومن ثمّ قد يلزم الاحتياط بتجنّب النكاح بينه وبين صاحب الخلية، بل حتى بينه وبين أبيه وأخيه وابنه، كما أنّ احتمال بنوّته لصاحبة البويضة الذي ذكرناه آنفاً ملزم بالاحتياط بعدم التناكح بينه وبينها، بل بينه وبين من يحرم بسببها على بنيها كأخيها وأُختها وابنها وبنتها ونحوهم.
( سابعاً ): ما هو حكم الحيوان المخلوق
بهذه الطريقة من حيث عائديته أو مِلْكيّته، هل يعود لمالك الحيوان الذي انتزعت منه البويضة أو الخلية؟ أم هو للقائم بعملية التخليق؟
ج: يعود الحيوان طبعاً لمالك الحيوان الذي انتزعت منه البويضة؛ لأنّ نموّ الجسم المملوك تابع له، وإذا نما الجسم لم يخرج عن ملك مالكه، سواء كان مع حفظ الصورة النوعية كنمو فرخ الحيوان حتى يكبر، أم مع تبديلها كنمو الحَب حتى يصير شجرة، ونمو البرعم حتى يكون في نهاية الأمر ثمرة، وذلك من الأحكام العرفية الارتكازية التي تحمل عليها الإطلاقات المقامية.
وعلى ذلك جرى الفقهاء فحكموا بأنّه لو غصب شخص حَبّاً فزرعه صار الزرع لمالك الحَب لا للغاصب، كما أنّ الحيوان ملك لمالك أُمّه.
هذا كلّه إذا أُخذت البويضة من غير إذن مالك الحيوان، أمّا إذا أُخذت بإذنه فالمتّبع هو نحو الاتفاق حين الإذن بين صاحب الحيوان والآخذ.
( ثامناً ): ما هو حكم لحم ولبن الحيوان الذي تصرّفوا في هندسته الوراثية، حتى أصبح دمه مشابهاً لدم الإنسان؟ وما هو حكم الدم المتخلّف من هذا الحيوان لو ذُكِّي؟
ج: أمّا لحم الحيوان ولبنه فهو بحكم لحم ولبن مماثله، ممّا يندرج في نوعه عرفاً، كالغنم والبقر والقطّة والكلب والإنسان، لدخوله في أدلة أحكام لبن ولحم ذلك الحيوان، فما دلّ على حلّيّة لحم ولبن الغنم - مثلاً - يدل على حليّة لحم ولبن الغنم الذي تصرّفوا في هندسته الوراثية؛ لأنّه من أفراده عرفاً. ومجرّد مشابهة دمه لدم الإنسان لا يخرجه عن موضوع تلك الأدلة. وأمّا الدم المتخلّف من هذا الحيوان لو ذُكّي فهو طاهر إذا كان الحيوان قابلاً للتذكية، لما دلّ على طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة؛ لعدم النظر في ذلك الدليل لتركيبة الدم وعناصره.
على أنّه لو فرض قصور ذلك الدليل كفى أصل الطهارة في البناء على طهارة الدم المذكور، وأمّا ما دل على نجاسة دم الإنسان فهو مختص بالدم المتكوّن في جسد الإنسان، ولا يعم كل دم مشابه لدم الإنسان في عناصره.
وبعبارة أُخرى: أنّ نسبة الدم لصاحبه عرفاً على أساس تكوّنه فيه، لا على أساس حمله لعناصر دمه.
( تاسعاً ): يجري الحديث عن إمكانية استنساخ بعض أعضاء الإنسان في المختبر وحفظها كاحتياطي له، أو لأيّ شخص آخر عند الحاجة إليها،
فهل يجوز ذلك؟ وهل يشمل الجواز الأعضاء التناسلية أو لا يجوز، باعتبار أنّها منسوبة للشخص فيحرم كشفها، مثلاً؟ وكذلك بالنسبة لاستنساخ الدماغ هل هو جائز؟
ج: يجوز ذلك بأجمعه حتى في الأعضاء التناسلية، ويجوز النظر إليها، لعدم كون نسبتها على حد النسبة التي هي المعيار في التحريم، فإنّ النسبة التي هي المعيار في التحريم هي نسبة الاختصاص الناشئة من كونها جزءً من بدن المرأة أو الرجل كيدهما ورجلهما، والمتيقّن من الحرمة حينئذٍ حالة اتصالها بالبدن، أمّا مع انفصالها فلا تخلو الحرمة عن إشكال. أمّا نسبة الاختصاص في المقام فهي ناشئة من كون أصلها من خليّته، ولا دليل على كونها معياراً في الحرمة.
والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
وفي ختام هذا الحديث بعد بيان الحكم الشرعي، نحن نحذّر من استغلال هذا الاكتشاف وغيره من مستجدّات الحضارة المعاصرة فيما يضر البشرية ويعود عليها بالوبال، فإنّ الله عظمت آلاؤه خلق هذا الكون لخدمة الإنسان ولخيره، كما قال عزّ من قائل:( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ) . وقال تعالى:( أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ) .
فلا ينبغي الخروج به عمّا أراده الله تعالى له، فنستحق بذلك خذلانه ونقمته، كما قال عزّ من قائل:( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللّهِ كُفْراً وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ * جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ ) .
ونسأله سبحانه أن يسدّدنا وجميع العاملين في حقل المعرفة لتحقيق الحقائق وإيضاحها، وخدمة البشرية وإصلاحها، إنّه وليّ التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل.
س٢: يجري الحديث الآن عن استنساخ بعض أعضاء الإنسان في المختبر وحفظها كـ ( احتياطي ) لمَن استنسخت عنه، فإذا احتاج إليها في وقت تركّب له. فلا يحتاج الإنسان أن ينتظر وقوع حادث لشخص حتى يؤخذ كبده أو كليته، مثلاً؟
ج: إذا كان المراد بذلك أخذ خليّة من عضو الإنسان - من دون أن تضر بذلك العضو - ثم زرعها حتى يتم منها عضو تام يحفظه كاحتياطي فهو أمر حلال بلا إشكال. وإن كان المراد غير ذلك فلابد من إيضاحه حتى يتيسّر لنا النظر في حكمه.
س٣: هل يجوز شرعاً تخصيب بيضة المرأة بخلايا من نفس المرأة؟ ( علماً أنّ الجنين الناتج صورة طبق الأصل
من أُمّه ) وهل الدخول في هذا البحث فيه إشكال، باعتبار أنّه بحث رسالتي للدكتوراه؟
ج: نعم يجوز ذلك. ويجوز الدخول في هذا البحث ونحوه من البحوث في نواميس الكون واستكشاف قدرة الله تعالى وعجيب خلقه، استزادة في تثبيت الحجّة. وقال تعالى:( سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ) .
نعم لابد من عدم اقترانه بمحرّم خارج، كالنظر لما يحرم النظر إليه، والحذر من الغرور العلمي الذي قد يجر للمهالك.
ومنه تعالى نستمد التوفيق والتسديد وهو حسبنا ونعم الوكيل.
تجميد الحيامن والتلقيح الصناعي
نعرض على سماحتكم أسئلة عن إمكانية الاستفادة من تجميد الحيامن والبيوض والأجنّة، للإفادة منها بعد وفاة أحد الزوجين، وعن مدى شرعيّة التلقيح الصناعي بأنواعه لمعرفة المباح منه والحرام والآثار المترتّبة عليه، باعتبار أنّ الشريعة أمرت المسلمين وحضّتهم على الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني. أرجو تفضّلكم بالإجابة عنها.
هذا والأسئلة على قسمين:
( أولاً ): الحالات المتعلّقة بحكم تجميد الحيامن والبيوض والأجنّة للإفادة منها بعد وفاة أحد الزوجين:
تمهيد
تمكّن العلم الحديث من تجميد حيامن الزوج وبيوض الزوجة والأجنّة المأخوذة من أصحابها. وقد ثبت أنّ عملية التجميد هذه تبقي الحيامن والبيوض والأجنّة حيّة عشرات السنين، ولهذا يمكن الإفادة منها بعد وفاة الزوجة أو الزوج في استمرار الإنجاب بحسب رغبتهما، وذلك في الحالات المذكورة في أدناه. فما هو موقف الشريعة من كل حالة مع مراعاة ذكر لحوق الطفل؟
س ١: بالإمكان زرع حيامن الزوج المجمّدة بعد وفاته في رحم زوجته لاستمرار الإنجاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد
ج: يحرم ذلك لأنّها تصير بوفاته أجنبية عنه، ويحرم إدخال مني الرجل في رحم المرأة الأجنبية. لكن لو حصل ذلك فالولد ينسب لهما إلاّ أنّه لا يرث من الرجل. وفي ميراثه من المرأة إشكال. فاللازم الاحتياط.
س ٥: كما يمكن العكس، تلقيح بويضة الزوجة المجمّدة بعد وفاتها بحيامن الزوج، ثم زرع اللقيحة في رحم أجنبية.
ج: الأحوط وجوباً ترك ذلك؛ لأنّها بعد وفاتها تكون أجنبية عنه ويكون أجنبياً عنها، وتلقيح البويضة بمني الأجنبي من أجل تكوين الإنسان مورد للإشكال. لكن لو حصل فالمولود ينتسب لهما. إلاّ أنّه لا يرث من المرأة. وفي ميراثه من الرجل إشكال، فاللازم الاحتياط.
س ٦: بالإمكان زرع جنين مجمّد مأخوذ من الزوجة المتوفّاة، وزرعه في رحم زوجة أُخرى أو أجنبية.
ج: لا بأس بذلك، بل هو واجب لو أمكن. وينسب الجنين حينئذٍ لأُمّه المتوفّاة ولأبيه صاحب الحيمن، ويرث منهما.
س ٧: بالإمكان إخصاب البويضة والحيمن المجمّدين للزوج والزوجة في داخل رحم الحيوان - لعدم صلاحية رحم الأُم على الإخصاب - ثم قتل الحيوان لاستخراج الجنين وإرجاعه إلى رحم الأُم الأصلية أو إلى رحم أجنبية.
ج: لا بأس بذلك - حتى لو توقّف على قتل الحيوان - إذا أُرجع إلى رحم أُمّه الأصلية، أو إلى رحم زوجة أُخرى للأب. وأمّا إرجاعه إلى رحم أجنبية فيجوز إذا بلغ مرتبة من النمو يخرج معها عن كونه منياً. ولا يجوز إذا لم يبلغ المرتبة المذكورة. وعلى كل حال ينسب الطفل لصاحب الحيمن وصاحبة البويضة ويرث منهما.
س ٥: بالإمكان تنشيط حيامن الزوج بسائل منوي مجمّد، مأخوذ من أجنبي لتلقيح بويضة الزوجة، ثم زرع اللقيحة في رحم الزوجة.
ج: إذا كان التلقيح بالحيمن وحده بعد تنشيطه، بحيث لا يدخل البويضة شيء من مني الأجنبي الذي يستعان به للتنشيط فلا بأس
به. وكذا إذا كان التلقيح بالحيمن والمني الذي يستعان به للتنشيط معاً بحيث يدخل شيء من المني المذكور البويضة، لكن زرع اللقيحة في رحم الزوجة بعد استهلاك المني الذي يستعان به للتنشيط واضمحلاله أو تحوله إلى عنصر آخر لا يصدق عليه المني، بحيث لا يدخل رحم الزوجة شيء من مني الأجنبي.
أمّا إذا كان زرع اللقيحة في رحم الزوجة قبل استهلاك المني الذي يستعان به للتنشيط، بحيث يدخل شيء من ذلك المني في رحم الزوجة ففيه إشكال، والأحوط وجوباً تركه. وفي جميع الصور، ينسب الطفل للزوجين ويرث منهما.
س ٦: بالإمكان استخدام مصل الدم المجمّد أو السائل المبيضي المجمّد المأخوذين من امرأة أجنبية، لتنشيط حيامن زوج ضعيفة، لغرض زرعها في رحم زوجته.
ج: لا بأس بذلك. وينسب الطفل للزوجين ويرث منهما.
س ٧: بالإمكان زرع رحم مجمّد أو مبيض مجمّد مأخوذين من أجنبية، لزوجة رجل تشكو من فقدان رحمها أو مبيضها لغرض الإنجاب.
ج: لا بأس بذلك. نعم لا يجوز اقتطاع الرحم أو المبيض أو أي جزء من المرأة المسلمة الميّتة لزرعه في الزوجة، بل لابد من دفنه معها. وإنّما يجوز اقتطاعه من المرأة الحيّة وإن كانت مسلمة، أو من المرأة الميّتة غير المسلمة.
س ٨: بالإمكان كذلك زرع أنبوب منوي ناقل للحيامن مجمّد يعود لرجل أجنبي أو لحيوان، لزوج يشكو من فقدان انبوبه المنوي.
ج: لا بأس بذلك إذا كان الأنبوب من الحيوان، وأمّا إذا كان من الإنسان، فلا يجوز أخذه من الإنسان الميّت المسلم، ويجوز أخذه من غيره، نظير ما تقدّم في السؤال السابق.
( ثانياً ): الأسئلة المتعلّقة بحكم التلقيح الصناعي:
س ٩: زوج حيامنه طبيعية ولكنّ سائله المنوي غير طبيعي، ففي هذه الحالة لا يتم الإخصاب ولا يكون إنجاب، إلاّ باتباع إحدى الحالتين:
أ - إمّا باستخدام سائل منوي طبيعي يؤخذ من أجنبي، ليكون بديلاً لسائل الزوج بغية تنشيط حيامنه،
ومن ثمّ زرعها في رحم الزوجة.
ب - وإمّا باستخدام سائل صناعي متكوّن من نفس عناصر السائل الطبيعي، ومن ثمّ زرعها في رحم الزوجة. فما موقف الشرع من الحالتين؟
ج: أمّا في الحالة الأُولى، فيظهر الجواب ممّا تقدّم في جواب السؤال الخامس.
وأمّا في الحالة الثانية، فلا إشكال، ويحل استخدام السائل الصناعي المذكور، ويُنسب الولد للزوجين ويتم التوارث بينه وبينهما.
س ١٣: إذا كانت حيامن الزوج ضعيفة ويمكن تنشيطها باستخدام دم أجنبي ومن ثمّ زرعها في رحم الزوجة. فهل يجوز ذلك؟
ج: نعم يجوز ذلك، ويُنسب الولد للزوجين، ويتمّ التوارث بينه وبينهما.
س ١٤: إذا كان مبيض الزوجة عاطلاً عن العمل، فهل يجوز أخذ بيضة من امرأة أجنبية وإخصابها بحيامن الزوج
ومن ثمّ زرعها في رحم الزوجة؟ ولمَن ينتسب الجنين إذا تكامل وولد؟
ج: الأحوط وجوباً ترك ذلك. وإذا تمّ ذلك وتكامل الجنين فإنّه ينسب للزوج وللأجنبية صاحبة البويضة. لكن في ترتب التوارث بينه وبينهما إشكال، واللازم التصالح.
س ١٥: رجل متزوّج من اثنين، رحم الزوجة الأُولى عاطل عن العمل، ورحم الثانية صالح، فهل يجوز أخذ بويضة الزوجة العاطل رحمها وتخصيبها مع حيمن زوجها، ثم زرعها في رحم الزوجة الثانية الصالح؟
ج: نعم يجوز ذلك وينسب الولد حينئذٍ للزوج وللزوجة الأُولى صاحبة البويضة ويتم التوارث بينه وبينهما.
س ١٦: إذا كان السائل المنوي للزوج لا يحتوي على حيامن، ورغب الزوج في أخذ حيامن من أخيه، أو من ابن عمّه، وإضافتها إلى سائله المنوي الصالح من أجل تلقيح بويضة زوجته، فهل يجوز ذلك؟ وفي حالة عدم الجواز، فهل يجوز للزوج بعد أخذ حيامن من أخيه
وإضافتهما إلى سائله، تطليق زوجته ليعقد عليها أخوه لتكون حليلة له فقط، دون أن يقترب منها، وبعد أن يتم تلقيح بويضة الزوجة، وبعد حصول الحمل يطلّقها الأخ لتعود إلى زوجها الأول حتى يلحق الطفل به؟
ج: لا يجوز ذلك إذا كان تلقيح البويضة بإدخال الماء في رحم المرأة. أمّا إذا كان التلقيح بإخراج البويضة من الرحم وتلقيحها في الخارج ثم إدخالها في الرحم، فيجري عليه ما يأتي في جواب السؤال ( ١٧ )، وعلى كل حال لو حصل ذلك فالولد يُنسب للأجنبي صاحب الحيمن ولصاحبة البويضة. نعم في التوارث بينه وبينهما إشكال واللازم الاحتياط. ولا ينسب الولد للزوج الذي أُخذ منه السائل المنوي الخالي من الحيامن.
أمّا تطليق الزوجة بعد أخذ الحيامن، ثم عقد صاحب الحيامن عليها، ثم إرجاعها له، فهو لا ينفع في تحقيق المطلوب.
س ١٧: إذا كان حيمن الزوج سليماً وكذلك سائله المنوي سليماً، ومبيض الزوجة سليماً أيضاً ولكن رحمها الذي يغذي الطفل عاطل، ففي هذه الحالة يمكن تخصيب حيمن الزوج وبويضة
الزوجة في أنبوب خارجي، ثم زرع اللقيحة بعد ذلك في رحم امرأة أجنبية صالح. فهل يجوز ذلك؟ وبمَن يلحق الطفل بعد الولادة؟ بصاحبة البويضة وهي الزوجة أو بصاحبة الرحم المغذي وهي الأجنبية؟
ج: الأحوط وجوباً ترك ذلك وعدم حضن المرأة بويضة ملقّحة بحيمن غير زوجها. إلاّ أن تطول المدّة، بحيث تخرج البويضة والحيمن عن كونهما ماءً، ويصدق عليها عرفاً أنّها جنين فيجوز حينئذٍ حضن الأجنبية له.
وعلى كل حال فالولد يلحق بالزوجين صاحبي البويضة والحيمن - ويرث منهما - لا بالحاضنة.
س ١٨: زوجة تعاني من تلف الرحم أو فقدانه، إلاّ أنّ مبيضها سليم، فيقوم الطبيب عندئذٍ بتخصيب بويضة الزوجة وحيمن الزوج في أنبوب، ثم زرعه في رحم أجنبية كحاضنة للجنين، بعد إجراء العقد عليها من الزوج دون أن يباشرها ( يواقعها ) وعندما يحصل الحمل ويولد الطفل يبادر الزوج إلى تطليق هذه
الزوجة الثانية ( المعقود عليها ) صاحبة الرحم الحاضن؛ ليلحق الطفل بالزوجة الأُولى صاحبة البيضة. فهل يجوز ذلك؟ وهل للثانية ( الحاضنة ) حق في إلحاق الطفل بها، وإن كانت البويضة ليست منها؟
وهناك ثمّة فرض آخر، وهو: لو أنّ الزوج واقع الثانية ( الحاضنة ) التي عقد عليها. واتفق أنّها حملت منه أيضاً عندئذ سيكون في رحمها جنينان فكيف يميَّز الأول من الثاني؟ علماً أنّ العلم الحديث يمكنه تشخيص عائدية كل طفل، وذلك عن طريق تطابق الأنسجة.
ج: لا بأس بذلك، ويلحق الطفل بالزوجة الأُولى صاحبة البويضة، لا بالحاضنة. أمّا في الفرض الآخر فكل طفل يلحق بصاحبة البويضة التي تكون منها. ومع الاشتباه لا طريق شرعي للتمييز، ويجوز الرجوع للطرق العلمية إذا أوجبت العلم بأُم كل من الطفلين.
س ١٩: إذا كان الزوج والزوجة كلاهما غير قادر على الإنجاب بسبب تلف خصية الزوج، وكذلك تلف مبيض
الزوجة، ولكن رحمها سليم يمكنه احتضان جنين. فهل يحق للزوج وبموافقة الزوجة أخذ حيامن من أخيه، أو من أجنبي، وإضافتها إلى سائله المنوي الخالي من الحيامن - بواسطة الطبيب - ثم يتم تخصيب هذا السائل الخليط ببويضة امرأة أجنبية، ومن ثمّ زرعه بعد التخصيب في رحم الزوجة؟
فما هو نظر الشرع الشريف في هذه العملية؟ وبمَن يُلحق الطفل بعد الولادة؟
ج: أمّا تخصيب بويضة المرأة الأجنبية بالسائل المذكور فالأحوط وجوباً تركه. وأمّا زرعه بعد التخصيب في رحم الزوجة فيجري عليه ما تقدّم في جواب السؤال ( ١٧ ) ولو حصل ذلك فيلحق الطفل بعد الولادة بصاحب الحيمن وصاحبة البويضة. لكن في ثبوت التوارث بينه وبينهما إشكال فاللازم التصالح.
س ٢٠: زوجة مبيضاها تالفان، فإذا أخذنا مبيضاً من امرأة أجنبية حيّة أو ميّتة، وزرعناه بجانب المبيض التالف للزوجة، ثم صار حملاً طبيعياً في رحمها، أو عن طريق الأنبوب، فهل
يجوز ذلك؟ ولمَن يُنسب الطفل؟
وكذلك الحال إذا كان رحم الزوجة تالفاً هذه المرة وليس المبيض، وزرعنا لها رحماً كاملاً مأخوذاً من أجنبية حيّة أو ميتة، وصار لها طفل، فما هو موقف الشرع من هذا الإجراء؟ ولمَن يعود الطفل؟
ج: يجوز ذلك في جميع الفروض ويلحق الولد بالزوجين. لكن ذكرنا في جواب السؤال السابع أنّه لا يجوز اقتطاع الرحم أو المبيض من المرأة الميتة المسلمة. فليلاحظ.
س ٢١: رجل خصيتاه تالفتان - وهما مصدر الحيامن والسائل المنوي - وزوجته مبيضها تالف أيضاً، فإذا زرعنا للرجل خصية من أجنبي أو من أخيه، وزرعنا للمرأة مبيضاً من أُختها أو من أجنبية، وصار لها طفل. فهل يجوز ذلك؟ ولمَن يُنسب الطفل؟
ج: يجوز ذلك ويُنسب الطفل للزوجين. لكن لا يجوز اقتطاع شيء من أجزاء المسلم الميّت، على نحو ما تقدّم في جواب السؤال السابع.
س ٢٢: إذا زرعنا للرجل خصية من
أجنبي، وكان مبيض زوجته سليماً، ولكنّ رحمها عاطل، فإذا أخذنا الحيامن من الخصية المزروعة للرجل، ولقّحنا بها بويضة زوجته في الأنبوب، وبعد حصول الجنين نزرعه في رحم أجنبية حتى يصير طفلاً فهل يجوز ذلك؟ وهل يكون لحوقه بصاحبة البويضة أو بصاحبة الرحم؟
ج: يجوز تلقيح بويضة الزوجة بالحيامن المذكورة، أمّا زرعها بعد التلقيح برحم الأجنبية فيجري فيه ما تقدّم في جواب السؤال( ١٧ ) أمّا الولد فيلحق بصاحبة البويضة. ويتم التوارث بينهما.
س ٢٣: رجل خصيتاه تالفتان، ولكنّ زوجته سليمة، وزُرعت له خصية من أجنبي أو من أخيه، تماماً كما تُزرع الكلية، وصار له طفل من زوجته السليمة، فما موقف الشرع من هذه الحالة؟
ج: يجوز ذلك. ويلحق الولد بالزوجين، ويتم التوارث بينه وبينهما. لكن تقدّم في جواب السؤال ( ٢١ ) المنع من اقتطاع شيء من أجزاء المسلم الميّت، أمّا من الحي فجائز.
س ٢٤: يصادف أن يصاب الزوج بتلف الأنابيب المنوية الموصلة للحيامن، ثم زرعت له أنابيب من شخص آخر أو من الحبل السرّي للطفل، ثم واقع زوجته وصار له طفل، أو يكون العكس: أنابيب مبيض زوجته الموصلة للبيوض تالفة ولكن مبيضها سليم، وزُرعت لها أنابيب من أجنبية، أو من الحبل السرّي للطفل وصار لها طفل. فما هو الموقف الشرعي من هاتين الحالتين؟
ج: يجوز ذلك، ويُلحق الطفل بالزوجين. ويتم التوارث بينه وبينهما. نعم، لا يجوز أخذ شيء من أجزاء المسلم الميت، كما تقدّم في جواب السؤال ( ٢١ ).
س ٢٥: شخص أُخذت منه مادّة منوية وبعد ذلك تزوّج امرأة، فهل يجوز تلقيحها بمادته المنوية المأخوذة منه قبل الزواج؟
ج: نعم يجوز.
س٢٦: رجل استخرج حيمناً من منيّه وطلب حفظه، وأوصى إن هو مات أن
تلقّح به زوجته بعد وفاته - لأنّه لم يرزق طفلاً - فمات ولُقّحت به زوجته بعد شهرين من وفاته وحملت منه:
أ - فما حكم هذه الوصيّة؟
ج: هذه الوصية غير نافذة؛ لأنّ المرأة بموت الزوج تخرج عن عصمته، ويحرم تلقيح المرأة بماء غير زوجها.
ب - وهل يجوز للمرأة القبول أو الرفض؟
ج: يجب على المرأة الرفض ويحرم عليها القبول.
جـ. وهل يعتبر الولد ولداً شرعياً للمتوفّى ولزوجته؟
ج: الأحوط وجوباً كونه ولداً شرعياً لهما، ولا يظهر أثر الاحتياط المذكور إلاّ في التوارث بينه وبين طبقات الميراث من طرفي الأب والأُم. أمّا إذا وقع التلقيح غفلة عن الحرمة المذكورة وبتخيّل جوازه شرعاً فيلحقه حكم ولد الشبهة في كونه ولداً شرعياً وارثاً وموروثاً.
نعم، لا يرث على كل حال من أبيه ولا من كل مَن يموت قبل انعقاد نطفته بتلقيح البويضة بالحيمن، بل ميراثهم ينحصر بمن هو
موجود من طبقات الميراث حين موتهم. وإنّما يرث الطفل المذكور احتياطاً أو جزماً من خصوص مَن يموت بعد انعقاد نطفته من طبقات الميراث من الطرفين.
د - وما حكم التوارث بين الولد وكل من أبويه؟
ج: يظهر الجواب عنه في جواب الفرع المتقدّم.
هـ - وما هو الحكم في الموارد المتقدّمة لو كان التلقيح بعد انتهاء العدّة؟
ج: لا أثر للعدّة؛ لأنّها بائنة، فلا فرق في جميع ما سبق بين كون التلقيح قبل خروج العدّة، وكونه بعد خروجها.
س ٢٧: امرأة توفّي زوجها فأخذوا من مادته المنوية ولقّحوا بها بويضة المرأة. والسؤال هنا:
أ - ما حكم أخذ المادة المنوية منه تكليفاً؟
ج: يشكل جوازه إذا لم تكن فيه مصلحة للميت، كما هو الغالب والدائم.
ب - هل يجوز للمرأة وللطبيب المعالج أن يزرق المادة في رحمها، أو يلقّح بها البويضة ويزرعها في رحمها بعد ذلك؟
ج: الأحوط وجوباً ترك ذلك؛ لأنّها بموته تصير أجنبية عنه فتدخل في المسألة الثالثة من أحكام الأولاد من الجزء الثالث من رسالتنا (منهاج الصالحين). فلتراجع.
ج - هل الولد يعتبر شرعاً ابناً للميت؟ وهل يستحق الإرث؟
ج: نعم يعتبر ابناً له، إلاّ أنّه لا يرث منه؛ لأنّه بموته تنتقل تركته لورثته المنتسبين له من أي طبقة من طبقات الميراث؛ لعدم انتساب الولد المذكور للميت بعد، ليحجبهم عن بعض الإرث أو عن تمامه، ولم ينتسب إلاّ بعد التلقيح ولا دليل على كون الانتساب المذكور موجباً لانقلاب ملك التركة، لاختصاص دليل ميراث الولد بالولد حين الموت.
س ٢٨: ما هو حكم ولد التلقيح من باب البنوّة، والنفقة، والإرث، والحضانة، وغيرها؟
ج: إذا كان التلقيح بين بويضة الزوجة وحيمن الزوج فتترتّب الأحكام المذكورة كافّة.
س ٢٩: إدخال ماء الرجل في رحم امرأة أجنبية بطريقة التلقيح الصناعي، هل يترتب عليها أحكام حد الزنا؟
ج: لا يترتّب الزنا ولا يجب الحدّ، وإنّما هو محرم لا غير.
س ٣٠: رجل زرع نطفته في رحم امرأة أجنبية بواسطة الوسائل الطبّية، متّفقاً معها على حمل الجنين مقابل مبلغ معيّن من المال؛ لأنّ رحم زوجته لا يتحمّل حمل الجنين، والنطفة مكوّنة من مائه هو وماء زوجته الشرعية، وإنّما المرأة الأجنبية وعاء حامل فقط، لكن حدثت بعدئذٍ مشكلة وهي:
أنّ المرأة المستأجرة للحمل طالبت بالولد الذي نما وترعرع في أحشائها، فما هو الحكم؟
ج: الولد ليس لها، وليس لها حق المطالبة به وبحضانته.
س ٣١: ما هو رأي سماحتكم حول عملية نقل خصية من شخص خصب جنسياً إلى شخص آخر عقيم يحتاج إلى خصية، لو فرضنا نجاح العملية جراحياً؟
مع العلم أنّ الخصية هي مكان إنتاج النطف والهرمونات الجنسية، وهذه النطف هي إحدى طرفي عملية الإخصاب لتكوين الجنين لاحقاً، ولمَن
تعود أُبوّة هذا الجنين؟
ملاحظة: الخصية تتكوّن من:
١ - أقنية تحتوي على خلايا تولّد النطف، وخلايا من نوع آخر تقوم بتغذية النطف، وأقنية أُخرى تقوم بنقل النطف إلى داخل الجسم.
٢ - خلايا بين الأقنية المولّدة للنطف تفرز هرمون التستوستيرون الذي يحفّز ظهور الصفات الجنسية الذكرية.
وكذلك المني يتكوّن من جزأين هما:
١ - السائل المنوي: يتكون ويفرز من غدّة البروستات وغدة كوبر، وبعض السوائل البربخ بالإضافة إلى القنوات المنوية.
٢ - النطف: يتم تكوينها وإنتاجها من خلايا موجودة في أقنية داخل الخصية، وثم تنتقل عبر قنوات ناقلة إلى داخل الجسم، ثم إلى خارج الجسم عبر الإحليل بعد أن تخلط مع السائل المنوي.
ج: العملية المذكورة جائزة في نفسها، لكنّها تستلزم كشف العورة ولمسها من قِبَل الطبيب المعالج فلا يجوز الإقدام عليها إلاّ مع الضرورة
الملزمة لذلك، هذا من جهة، ومن جهة أُخرى تعود أُبوّة الولد للثاني الذي انتقلت له الخصية السليمة.
طفل الأنابيب
س ٣٢: سماحة السيد نعرض عليكم الحالات المتّبعة في عمليات الأنابيب، نرجو بيان أيّ الحالتين يجوز العمل بها؟
الحالة الأُولى:
يجري سحب أو استئصال نسيج أو جزء من النسيج الذي يتولّد فيه الحيمن من الخصية، وهذه العملية تكون بواسطة جهاز يؤدّي العملية بسرعة عالية، وفي نفس الوقت يتم في مكان آخر سحب البويضة من الزوجة من الرحم، وذلك يتم طبعاً بعد تحديد وقت نزول البويضة، وربّما بواسطة طبيب أو طبيبة أو كلاهما معاً. ويتم خارجاً زرع النسيج - الذي يولّد الحيامن - مع البويضة داخل أنبوب؛ وذلك لاختصار وتجاوز مرحلة انتقال الحيمن من الزوج إلى الزوجة في الحالة
الطبيعية؛ وذلك لأنّ هذه المدّة هي السبب في عدم وصول الحيامن بنفس القوّة إلى البويضة؛ وذلك لضعفها ولهذا لا يتم التلقيح. ثم يبقى التلقيح خارج رحم المرأة لمدّة ( ٤٨ ) ساعة تقريباً في الحاضنة، ثم يتم بعدها إعادة البيضة المخصبة إلى رحم الزوجة وربّما أيضاً بواسطة طبيب أو طبيبة.
الحالة الثانية:
يتم سحب الحيامن والسائل المنوي من خصية الزوج بواسطة إبرة سحب وتوضع في حاوية زجاجية - أنبوب - مع منشّطات أو مقوّيات للحيامن، وتبقى في الحاضنة لفترة محدودة، ثم يتم حقن هذا السائل في رحم المرأة، وذلك بواسطة حاقنة خاصة بذلك يدوياً بواسطة طبيب أو طبيبة.
ج: يجوز القيام بالعمليتين المذكورتين أعلاه إلاّ أنّه حيث كان القيام بهما يستلزم كشف العورة ولمسها من قِبَل الطبيب المعالِج، فلا يجوز الإقدام عليها إلاّ مع حصول الحرج من عدم الإنجاب.
ويلزم التأكّد من عدم حقن ماء آخر غير ماء الزوج، كما يلزم تقديم المماثل في الذكورة والأُنوثة في إجراء العملية مع الإمكان.
س ٣٣: الحيمن والبويضة من الذكر والأُنثى إذا وضعت في الأنابيب الطبّية، هل هذا العمل جائز أم لا إذا كان من امرأة وزوجها؟
ج: نعم هو جائز، ولكنّه يلزم منه كشف العورة ولمسها فيجري فيه ما سبق.
س ٣٤: في حال عدم الإنجاب - العقم - يقوم الأطبّاء بفحص الزوجين، ويبدأ الفحص بالرجل فإذا كان سليماً فحص حال المرأة وإلاّ اكتفى به. هل يجوز للرجل الكشف أمام الطبيب وإعطاء منيّه للاختبار، ويُؤخذ المني في بعض الأحيان بطريقة العادة السرّية؟ وهل يجوز أخذ منّي الرجل والمرأة ووضعه في أنبوب معيّن ثم يدخل في رحم المرأة؟ وهل يجوز أخذ الحيوان المنوي من داخل الخصية بواسطة عملية جراحية ثم
يتم تلقيح بويضة المرأة به، ووضعها في أنبوب ثم بعد فترة تلقّح المرأة بها؟
ج: ١ - إنّما يجوز كشف العورة إذا كان عدم الإنجاب يسبّب نوعاً من الحرج، ولا يجوز أخذ المني من طريق العادة السرّية إلاّ مع انحصار الأمر بها حينئذٍ.
٢ - ولا مانع من جمع ماء الرجل والمرأة في أنبوب ثم إدخاله في رحم المرأة.
٣ - ولا مانع أيضاً من أخذ الحيوان المنوي من داخل الخصية وتلقيح بويضة المرأة به ثم وضعها في الرحم.
س ٣٥: يقوم بعض الأطباء هذه الأيام بخلط ماء الرجل ( الزوج ) مع ماء المرأة ( الزوجة ) في أنبوبة الاختبار، فيتكوّن من ذلك عدّة أجنّة هي بداية النشوء البشري، والحال هنا يختلف عن التلقيح الطبيعي في الرحم، حيث يتكوّن عادة جنين واحداً أو اثنان أو ثلاثة أو لكن في الأنبوبة يؤدّي إلى تكوّن عدّة أجنّة، فهل يجب زرعها جميعاً في رحم الأُم، علماً بأنّ ذلك قد يؤدّي إلى هلاكها؟ وهل يجوز انتقاء جنين واحد وقتل
الباقي؟ وهل تجب الديّة، علماً بأنّ عدد هذه الأجنّة قد يكون كثيراً جداً بحيث يصعب عدّه، فما الحكم في ذلك؟
ج: لا بأس بقتل هذه الأجنّة ما لم تلج فيها الروح. نعم الأحوط وجوباً وضع ما يمكن وضعه في رحم الأُم إذا رضيت بذلك، ولا يجب عليها الرضا به.
س ٣٦: في بعض المستشفيات قد يتعرّض المريض لملامسة الممرضات أثناء أخذ النبض وقياس الضغط، فما هو الحكم؟
ج: إذا بلغ الأمر حدّ الضرورة فلا بأس وإلاّ فلا يجوز.
س ٣٧: هل يجوز للطبيب أن يكشف على المرأة في:
١ - حالة اعتقادها بأنّ هناك ضرورة لا يمكن تأخيرها؟
ج: المدار في جواز الفحص للطبيب احتماله احتمالاً معتدّاً به حاجة المرأة الصحّية لفحصه، بحيث لا تقوم الطبيبة مقامه في ذلك، ولا أثر لاعتقاد المرأة المريضة أو احتمالها في تشخيص وظيفته، بل أثر ذلك جواز بذل نفسها لفحصه، وإن لم يجب عليه الاستجابة.
نعم إذا كان اعتقادها وجود الحاجة لفحصه موجبة لعدم اطمئنانها لفحص الطبيبة وعدم استجابتها لعلاجها، وكانت في حاجة للعلاج رجع ذلك إلى حاجتها لفحصه، وجاز له الفحص وإن اعتقد استغناءها بالطبيبة عنه.
وكذا إذا كانت في حالة نفسية سيّئة يخشى منها نتيجة الاعتقاد المذكور، وإن كان هو يعتقد عدم حاجتها للعلاج عضوياً؛ لأنّها حينئذٍ في حاجة إلى فحصه لها من الناحية النفسية.
٢ - حالة شك الطبيب بضرورة الكشف على المرأة عند ادعائها الضرورة؟
ج: يظهر الجواب ممّا سبق.
٣ - حالة تأكد الطبيب بعدم ضرورة الكشف على المرأة لكن المرأة تطلب الكشف؟
ج: يظهر الجواب مما سبق.
س ٣٨: عند أخذ عيّنة الدم من المريض، قد لا يجد الرجل رجلاً بل يوجد امرأة وكذا العكس. هل يجوز أخذ العيّنة في غير حالة الضرورة، بل في حالة الكشف العام حينما يريد
الإنسان أن يتأكّد على صحّته العامة؟
ج: إذا لم تكن هناك ضرورة فلا يجوز الكشف إذا استلزم المس أو النظر المحرّمَين.
- أو في حالة الشك هل هناك ضرورة أو لا؟
ج: إذا كان احتمال الحاجة معتدّاً به بحيث يتحقق الخوف من الضرر، جاز ذلك.
- وهل يجب عليه الذهاب إلى المستشفيات الخاصة المتوقّفة على بذل المال لتحصيل المماثل؟
ج: نعم يجب إذا لم يكن المال مضرّاً به.
- وكذا في حالة العلاج، فهل جواز الذهاب إلى المستشفى يتوقّف على عدم إمكان الحصول على المماثل؟
ج: نعم يتوقّف على عدم إمكان الحصول على المماثل إذا كان العلاج مستلزماً للنظر والمس المحرّمَين.
- ولو كان يتوقّف على قطع مسافة بأن يسافر من قم إلى طهران أو من الإحساء إلى الدمّام. هل يجب مع الإمكان؟
ج: نعم يجب إلاّ إذا كان قطع المسافة حرجياً.
س ٣٩: اضطررت لعرض زوجتي لمرض ألمّ بها على أكثر من طبيبة نسائية ولكنّها لم تُشف ولم تتحسّن، وعلمت بوجود طبيب ماهر قد عالج نفس الحالة بنجاح، فهل لي أن أعرضها عليه، علماً بأنّ مرضها نسائي يستلزم كشف العورة ولمسها؟
ج: يجوز ذلك في الفرض المذكور.
س ٤٠: هل يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الطبيبة للفحص لغرض طلب الولد؟
ج: إذا كان في ذلك ضرورة عرفيّة فلا بأس.
س ٤١: المرأة المصابة بالعقم هل يجوز لها العلاج منه وإن أدّى إلى التكشّف أمام الطبيبة أو الطبيب؟
ج: الظاهر جواز التكشّف المذكور من أجل التداوي في المقام وغيره، وخصوصاً إذا كان تحمّل العقم حرجياً كما هو الغالب.
س٤٢: ما الحكم في فحص المرأة
ظاهرياً مع العلم بأنّه يشمل فحص الصدر ولمسه، وهذا مطلوب لإكمال الفحص على القلب والتنفّس؟
ج: لا بأس بذلك مع حاجة المريضة، لكن لابد من الاقتصار على أقل مقدار من اللمس والنظر المحرّمَين.
س ٤٣: هل يجوز للأجنبي النظر للأعضاء الباطنية للمرأة مثل: كبدها أو قلبها أثناء العملية الجراحية من دون ضرورة كما قد يتحقق لبعض الممرّضين في غرفة العمليات الجراحية؟
ج: لا يجوز إلاّ عند الحاجة من أجل صحّتها.
س ٤٤: هل يجوز النظر لصورة أعضاء المرأة على الأشعة للشخص الأجنبي من دون ضرورة إذا كان يعرفها؟
ج: نعم يجوز.
س ٤٥: بعض الفنّيّين في قسم العمليات يحضرون عمليات تجري في الأعضاء التناسلية دون الحاجة لوجودهم
سوى لملاحظة كيفية إجراء العملية والاستفادة الشخصية، ما هي نظرة الشارع المقدّس في ذلك؟
ج: يحرم عليهم القيام بذلك إذا استلزم النظر المحرّم إلاّ أن يتوقّف عليه التعلّم الواجب كفاية من أجل سدّ حاجة المؤمنين المتوقّعة.
س ٤٦: بعد إجراء العملية يجب على الموظّفين ملاحظة المريض من حيث العلامات الحيوية ( كقياس الضغط ودرجة الحرارة والنبض ) علماً أنّ المريض تحت مفعول التخدير، ما الحكم في ذلك إذا كان الموظّف رجل والمريض امرأة. والعكس كذلك؟
ج: اللازم الاقتصار في ذلك على صورة انحصار الأمر بالجنس المختلف مع الحاجة الصحّية الملزمة بذلك.
س ٤٧: تجري عمليات تناسلية للرجل مثل عملية غدّة البروستات بحضور الممرّضات المساعدات كفنيّات التخدير، ما الحكم في حضورهنّ للمساعدة؟
ج: جوابه كالجواب السابق.
س ٤٨: تتوقّف دراسة طالب الطب على بعض المقدّمات منها: الحضور عند طبيب حاذق أثناء قيامه بعملية جراحية، فقد يضطرّ الطالب المتعلّم إلى النظر إلى المرأة، وقد يضطر أحياناً إلى لمس الجسد بل العورة وهذا شيء يتوقّف عليه دراسة الطب في هذا الزمان، فهل تجوز دراسة الطب والحال هذه اختياراً؟
ج: لا يجوز ذلك إلاّ إذا توقّف عليه التعلّم الواجب، ولا يجب التعلّم إلاّ إذا توقّف عليه سدّ الحاجة المتوقّعة للمؤمنين.
س ٤٩: وكذا الحال بالنسبة للفتاة التي ترغب في دراسة الطب والحال كما بُيّن في السؤال السابق؟
ج: الحال فيها هو الحال في الرجل. نعم يترجّح طبّ النساء للمرأة لأنّها أحرى بسدّ حاجة النساء.
س ٥٠: بعض الأطبّاء يطلبون من الطلاب الاطلاع على بعض المراجع الطبّية حيث إنّها تحتوي على صور
طبيعية ورسومات للأعضاء التناسلية لكلا الجنسين للإفادة والبحث، ما رأي الشرع في ذلك؟
ج: لا بأس بالنظر حينئذٍ إلاّ إذا كان بريبة وتلذّذ فإنّ الأحوط وجوباً حينئذٍ تركه.
س ٥١: هل يجوز فحص الأعضاء التناسلية من قِبَل طلاّب تدريب الطب؟
ج: يجوز ذلك إذا كان برضا المريض وتوقّف عليه تعلّم الطالب، ووجب التعلّم كفاية من أجل سدّ حاجة المؤمنين المتوقّعة.
س ٥٢: طالب طبّ النساء والولادة يطلب منه إجباراً فحص الأعضاء التناسلية للمرأة وإلاّ سيرسب. فما الحكم في ذلك؟
ج: لا يجوز ذلك إلاّ إذا توقّف على ذلك نجاحه، وكان في نجاحه دفع ضرورات متوقّعة للمؤمنين لا تنهض بها النساء الطبيبات.
س ٥٣: في المستشفى يطلب من المرضى الذين يعانون من عدم الإنجاب عيّنة من السائل المنوي، ويتم استخراجها بإحدى الأُمور التالية:
أ - تدليك غدّة البروستات من فتحة
الشرج بواسطة إصبع الطبيب أو الممرّض؟
ب - استخدام العادة السرّية؟
جـ - استخدام آلة خاصة للتدليك؟
ج: أ - التدليك المذكور جائز في نفسه إلاّ أن يستلزم لمس العورة والنظر إليها، فلا يجوز إلاّ أن يتوقّف التخلّص من العقم عليه.
ب - يحرم القيام بالعادة السرّية إلاّ مع الاضطرار إليها من أجل التخلّص من العقم، وعليه فيلزم تقديم التدليك على العادة السرّية مع الإمكان.
ج - لا باس بها إلاّ أن تؤدّي إلى نظر الأجنبي للعورة، فيتوقّف جوازها على انحصار التخلّص من العقم على ذلك.
س ٥٤: حالة مرضية استدعت أن يطلب الطبيب من مريضه فحص السائل المنوي بعد تعذّر إخراجه بالطريق الشرعي؛ لأنّ إخراجه لابد أن يكون عند الطبيب، فهل يجوز استعمال العادة السرّية ( الاستمناء )؟
ج: إذا اضطرّ المريض إلى ذلك جاز له، ذلك مع تعذّر إخراجه مع الزوجة أوّلاً.
س ٥٥: إذا أراد شخص أن يختبر مدى قدرته على الإنجاب، فطلب منه الطبيب أن يخرج السائل المنوي ليفحصه؟
ج: ما دام غير مضطر لذلك فلا يجوز له الاستمناء.
اللولب وموانع الحمل
س ٥٦: إحدى أخواتنا المؤمنات حيث إنّها طبيبة نسائية تعتبر طريق منع الحمل عند المرأة باستعمال اللولب طريقة واسعة الانتشار، وقد قرأت في مجلّة طبّية أجنبية ما يلي:
نظريات عمل اللولب:
١ - يتعارض مع التصاق البويضة المخصبة في جدار الرحم وتسمّى مرحلة ( BLAST:CYST ).
٢ - يقلّل أنزيمات الرحم فيمنع الحمل.
٣ - يمنع وصول الحيمن إلى قناة فالوب أي إلى البويضة.
س ٥٦: هل يمكن بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة من جواز استعمال اللولب أو عدم الجواز؟
ج: لمّا كان منع التلقيح وتخصيب البويضة حلالاً والمحرّم هو
قتل البويضة بعد تخصيبها، فعلى ضوء ما تقدّم لا يُعلم بأداء استعمال اللولب إلى قتل البويضة بعد تخصيبها؛ وعليه يحل استعمال اللولب. والله سبحانه وتعالى العالم.
س ٥٧: إنّي طبيبة اختصاصية بأمراض النسائية والتوليد والجراحة النسائية العامة، ومعي لفيف من الطبيبات بنفس الاختصاص، نقوم بإجراء عمليات وضع اللولب وعقد الأنابيب وإعطاء حبوب منع الحمل. وهذه العمليات تارة تكون بإذن الزوج وأُخرى بدون إذنه.
سيّدي نرجو بيان حكم الشريعة المقدّسة من خلال سماحتكم في:
١ - ما حكم إجراء هذه العمليات؟
ج: لا بأس بذلك كلّه مع حاجة المرأة لذلك لإضرار الحمل بها ضرراً معتدّاً به، سواء رضي الزوج أم لا. نعم لا يجوز وضع اللولب إذا علم أنّه يقتل النطفة بعد انعقادها.
٢ - هل يشترط إذن الزوج عند القيام بإجراء هذه العمليات؟
ج: إذا لم يكن الحمل مضرّاً بالمرأة لكنّها ترغب في منع الحمل
لا بأس؟
أ - بإجراء العمليات التي تمنع الحمل مؤقّتاً وبإذن الزوج، أمّا العمليات التي توجب العقم فالأحوط وجوباً تركها، وكذا العمليات التي تمنع الحمل مؤقّتاً إذا لم يأذن الزوج.
ب - كما لا بأس بوضع اللولب إذا لم يعلم بأنّه يقتل النطفة بعد انعقادها، لكن الأحوط وجوباً اشتراط رضا الزوج به.
ج - كما لا بأس بوصف حبوب منع الحمل وإن لم يحرز رضا الزوج. نعم الأحوط وجوباً للزوجة أن لا تستعمل الحبوب المذكورة إلاّ برضا الزوج.
د - إذا استلزمت العمليات أو وضع اللولب كشف العورة أو لمسها فاللازم الاقتصار على صورة حاجة المرأة لكشفها، إمّا من أجل مراجعة طبّية، أو لحاجتها لمنع الحمل وإن لم يبلغ الأمر الضرر.
٣ - ما حكم الأموال التي نحصل عليها نتيجة إجراء مثل هذه العمليات؟
ج: تحل الأُجرة والأموال المأخوذة في الموارد التي يحل فيها العمل، وتحرم في الموارد التي يحرم فيها العمل.
س ٥٨: كثر في الآونة الأخيرة استعمال اللولب، فما هو الحكم الشرعي له؟
ج: إذا لم يعلم بأنّ اللولب يقتل النطفة بعد انعقادها فهو جائز في نفسه، إلاّ أنّه حيث كان وضعه يستلزم كشف العورة ولمسها من قِبَل الدكتورة فلا يجوز الإقدام عليه إلاّ مع الاضطرار إلى ذلك، أو يتم وضعه في أثناء مراجعة اعتيادية للدكتورة بحيث لا يكون المحذور المذكور من أجل وضع اللولب، وإنّما من أجل المراجعة الاعتيادية.
س ٥٩: هل يجوز استعمال مانع الحمل المسمّى باللولب ولو استعمل لفترة طويلة (٥، ٦) سنوات وأحدث بعض التغيّرات في الدورة الشهرية، إذ حصلت إفرازات لونها جوزي قبل الدورة وبعدها بثلاثة أيام ثم تنقطع، وتحصل إفرازات دموية متوسّطة - تغمس القطنة - في بعض الأحيان، في الصلاة وغيرها. ما حكم هذه الحالات؟
ج: لا بأس باستعمال اللولب إذا لم يعلم بكونه يقتل البويضة بعد التلقيح. وأمّا الإفرازات فإذا صدق عليها الدم جرى عليها حكم الحيض والاستحاضة بالشروط المقرّرة للحيض والاستحاضة، ولا مجال لتفصيلها في هذه العجالة، بل يرجع فيها لرسالتنا العملية أو السؤال الشفهي.
س ٦٠: هل يجوز عقد بيت الرحم إذا
كان الزوجان لا يريدان الإنجاب؟
ج: الأحوط وجوباً ترك ذلك إذا كان موجباً للعقم الدائم، وإن كان موجباً لمنع الحمل مؤقّتاً فلا بأس به.
س ٦١: ما حكم استعمال الأدوية ( إبَر، شراب، حبوب ) المانعة للحمل برضا الطرفين أو عدمه، وهل يسمح لذوي الأعذار الشرعية كالمرض ونحوه؟
ج: يجوز استعمال ذلك إلاّ أن يؤدّي إلى ضرر بليغ بالصحّة. نعم مع عدم الضرورة الصحّية الأحوط وجوباً للزوجة إرضاء الزوج بذلك.
س ٦٢: هل يجوز للمرأة استخدام حبوب مانع الحمل أو ما شبه ذلك مثل زرق الإبر؟
ج: نعم يجوز ذلك إلاّ أن يكون ذلك مضرّاً بها ضرراً شديداً.
س ٦٣: إذا كان استخدام اللولب لمنع الحمل أفضل لبعض النساء، فهل يجوز إذا استلزم فحص الطبيب أو الطبيبة للمرأة؟
ج: يتوقّف ذلك على الحاجة لمنع الحمل، ولزوم الضرر المعتدّ به من بقيّة موانع الحمل، بمرتبة يلزم الحرج من عدم استعمال اللولب.
وإذا دار الأمر بين الطبيب والطبيبة لزم ترجيح الطبيبة.
هذا إذا كان استعمال اللولب في نفسه حلالاً لعدم العلم بأنّه يوجب قتل النطفة بعد انعقادها.
س ٦٤: إذا كان استخدام وسائل منع الحمل غير أمينة، أو ذات عوارض جانبية، فهل يحق للمرأة اختيار اللولب في هذه الحالة؟
ج: يجوز اختيار اللولب وفق الشروط المتقدّمة في جواب السؤال السابق.
س ٦٥: تأتي بعض النساء إلى المستشفى لإجراء عملية ربط الرحم لعدم رغبتها في الإنجاب، علماً بأنّها لا تشتكي من أي مرض يعرّض حياتها للخطر:
أ - ما الحكم بالنسبة للمرأة؟
ب - ما الحكم بالنسبة للمشاركين في العملية من الرجال والنساء؟
ج: إذا كانت عملية الربط المذكورة تؤدّي إلى منع الرحم من الإنجاب كلّيّاً بحيث لا يمكن إعادته إلى حالته الطبيعية فالأحوط
وجوباً تركها، إلاّ مع حاجة المريضة لها صحّياً، كما أنّ الأحوط وجوباً عدم قيام الطبيبة والممرّضين بها إلاّ في الحالة المذكورة.
وأمّا إذا كان يمكن إعادة الرحم إلى حالته الطبيعية بعملية ثانية فيجوز القيام بالعملية المذكورة للمرأة نفسها ولمَن يقوم بالعملية. ولكن لابد من تجنّب إيقاعها بوجهٍ يؤدّي إلى لمس بدن المرأة أو النظر إليه من قِبَل الرجل الأجنبي، فإنّه لا يحل ذلك إلاّ مع حاجة المرأة للعملية وتوقّف العملية على الأمر المذكور.
س ٦٦: ما حكم العملية التي تسمّى بـ ( عقد الرحم ) لإيقاف الإنجاب؟
وإذا أمر الزوج بها فهل تجب إطاعته أم لا، وإن كان هناك ضرر يترتب على عدم الطاعة؟
وإذا تمّت العملية فهل هناك حل أو تكفير بعد الندم؟ وما حكم اللولب كذلك؟
ج: الأحوط وجوباً عدم القيام بعملية عقد الرحم المؤدّية إلى عدم القدرة على الإنجاب حتى في المستقبل، ولا تجب طاعة الزوج لو أمر بها. ومع القيام بها لا يترتّب عليه إلاّ الاستغفار والتوبة.
وأمّا اللولب فهو جائز مع عدم العلم بكونه يقتل النطفة، ولكنّه حيث يوجب كشف العورة وملامستها من قِبل الطبيبة فلا يجوز
الإقدام عليه إلاّ مع الاضطرار إلى منع الحمل وانحصار الأمر به.
س ٦٧: هل يجوز للمرأة أن تستعمل موانع الحمل من دون إذن زوجها؟ وهل يجوز لها أن تخفي عليه ذلك؟
ج: لا يخلو عن إشكال والأحوط وجوباً استئذانه، إلاّ أن تخشى الضرر من الحمل، فلا يجب عليها استئذانه، بل يجوز أن تخفيه.
الإجهاض
نعرض على سماحتكم حالات الإجهاض، ونرجو بيان مدى شرعيّتها.
يقسّم الأطبّاء المتخصّصون حالات الإجهاض إلى قسمين:
( أوّلاً ): الإجهاض القسري:
وهو على نوعين:
أ - إجهاض قسري لأسباب مرضية، تصيب المرأة الحامل التي يخشى منها على حياتها، فيما إذا استمرّ الحمل إلى نهايته، مثلاً أمراض الجهاز التناسلي، وأمراض الرحم المختلفة ( الفايروسية، والمكروبية ) وكذلك أمراض الغدّة النخامية والغدّة الدرقية، وغيرها.
ب - إجهاض قسري لأسباب طبّيّة، حيث إنّ هناك أمراضاً يخشى منها على حياة المرأة الحامل في حالة استمرار الحمل إلى نهايته، وذلك إذا كانت مصابة بواحد منها، مثلاً: أمراض القلب والشرايين وأمراض الكلى، وأمراض الرئتين، وما إلى ذلك ممّا يقرّره المتخصّصون.
( وثانياً ): الإجهاض المتعمّد أو الطوعي:
يعزى هذا النوع من الإجهاض إلى الأسباب الآتية:
أ - الحمل غير الشرعي، للتخلّص من العار والفضيحة.
ب - إذا كان للأبوين عدد من الأولاد ولا يرغبان بولادات أُخرى، وبخاصة إذا كانت الولادات متقاربة لما يلاقيان من أتعاب.
ج - بسبب الوضع الاقتصادي المتدنّي للعائلة.
هذه هي حالات الإجهاض المختلفة، فما هو موقف الشرع الأقدس من كل حالة من خلال الأسئلة الآتية:
١ - في أيّة حالة من الحالات المذكورة أعلاه يكون الإجهاض مباحاً أو محرّماً أو مكروهاً؟
ج: يحرم الإجهاض في جميع الحالات المذكورة إلاّ في حالة واحدة، وذلك بأن تتوقّف حياة الأُم على الإجهاض، حيث يكون في بقاء الحمل موتها أو موت الحمل معاً، فيجب حفظها بالإجهاض بعد أن كان الجنين ميتاً على كل حال.
نعم لابد في هذه الصورة من التأكّد من تعذّر حفظهما معاً ولو ببعض الإسعافات والعلاجات؛ لأنّ مسؤولية قتل النفس عظيمة، فلابد في الإقدام عليها من التأكّد من تحقّق الضرورة الملزمة بذلك.
٢ - في أي طور من أطوار الجنين تكون الحرمة أو الإباحة أو الكراهة؟
ج: يحرم الإجهاض في جميع أطوار الجنين، ولا يفرّق بين الأطوار في ثبوت الحرمة الشديدة، وفي ثبوت الكفّارة بذلك.
٣ - إذا كان الإجهاض المتعمّد محرّماً، فهل يحرم هذا النوع أيضاً، إذا تمّ قبل نفخ الروح في الجنين، علماً أنّ الأطبّاء المتخصّصين حدّدوا مدّة نفخ الروح بـ ( أربعين ليلة ) ابتداءً من التلقيح، وهي مدّة مكوث النطفة في الرحم وبعدها تدبُّ الروح في الجنين؟
ج: نعم يحرم الإجهاض حتى قبل نفخ الروح. وفي صحيح إسحاق بن عمّار: ( قلت لأبي الحسن (عليه السلام) [ يعني: الإمام الكاظم ]: المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها. قال: لا. فقلت: إنّما هو نطفة. فقال:إنّ أوّل ما يخلق نطفة )(١) . ولا ينبغي التساهل في هذا المحرّم العظيم.
س ٧١: هل هناك موارد يجوز فيها الإجهاض؟
ج: لا يجوز الإجهاض إلاّ إذا توقّفت عليه حياة الأُم، بحيث يدور الأمر بين الإجهاض وموت الأُم مع جنينها. وكذا إذا دار الأمر بين حياة الأُم وحياته في مورد يعلم بأهمّية حياتها.
____________________
(١) وسائل الشيعة ج: ١٩ ص: ١٥.
س ٧٢: هل يجوز للمرأة المغتصبة إجهاض الجنين؟
ج: لا يجوز إجهاض الجنين حتى لو كانت مغتصبة؛ لأنه من قتل النفس المحرّمة.
س ٧٣: حملت امرأة حملاً وبلغ عمره ( ٦ ) أشهر وقد ثبت بالتشخيص الشعاعي أنّه مشوّه الخلقة تماماً، ويقول الأطبّاء إنّه بمجرّد ولادته يموت، وهو ما دام حملاً في رحم أُمّه يسبّب بقاؤه تكوّن مياه غير طبيعية في بطنها، وقد ثبت طبّيّاً أنّ ذلك خطر على سلامة الأُم، ففي هذه الحالة هل يجب إجهاضه شرعاً أم لا؟
ج: إذا ثبت أنّه يموت عند الولادة فحياة أُمّه مقدّمة على حياته.
س ٧٤: رجل رُزق ولد مشوّه الخلقة لتخلّف عقله وتقرّح جسده كلّه، وبعد عرضه على الطبيب المختص نفى أن يكون له علاج، وعزى ذلك إلى عامل وراثي وحذّر الأب والأم من الإنجاب. وبعد مرور عشر سنوات على هذا الطفل عانوا معاناة لا يمكن وصفها
أقلّها هو تبديل ملابسه كلّها خلال أربع وعشرين ساعة؛ لتلوّثها بالدماء والمواد التقرّحية، ثم حملت المرأة مع شدّة تمنّعها من الحمل، وبعد عرضها على الطبيب احتمل احتمالاً قويّاً بأنّ الحمل مصاب بعين ما أُصيب به الطفل المذكور، فهل يجوز لهما - الأب والأم - إسقاط الحمل ومنعه؟
ج: لا يجوز إسقاط الطفل المذكور، وهذه المعاناة من الابتلاء الذي يزيد في الحسنات أو يكفّر عن السيئات إن شاء الله تعالى.
س ٧٥: بعد تشخيص الطبيب الأخصّائي لامرأة حامل وتأكّد لديه بواسطة الكشف بجهاز ( السونار ) أنّ الجنين الذي هو بعمر خمسة أشهر مشوّه ويوصي بإسقاطه. هل جائز شرعاً إجراء عملية الإسقاط ( الإجهاض ) في هذه الحالة؟
ج: لا يجوز ذلك، بل هو من قتل النفس المحترمة البريئة.
س ٧٦: في حالة الإجهاض ( قد يوضع الجنين ) الميت في زجاجة، وهناك
مسائل:
١ - ما حكمه من حيث الطهارة والنجاسة؟
ج: إذا كان قد ولجته الروح فهو نجس، بل الأحوط وجوباً إجراء حكم النجس عليه مطلقاً.
٢ - ما حكم مسّه من حيث لزوم الغسل وعدمه؟
ج: يجب الغسل بمسّه إذا كان قد ولجته الروح، ولا يجب في غير ذلك.
٣ - هل يجب دفنه أو لا، ومَن هو المسؤول عن ذلك؟ وما هو التكليف الملقى على عاتق الطبيب تجاه ذلك؟
ج: يجب دفنه إذا كان محكوماً بالإسلام، والوجوب المذكور كفائي ولابد من وقوعه بإذن الولي، كسائر الموتى.
التّشريح
س ٧٧: في كلّيّة العلوم الطبّية يتدرّب الطلاّب من الناحية التشريحية على جثث غير إسلامية تُجلب من الدول الأجنبية؟
أ - ما حكم تشريح هذه الجثث؟
ب - هل يجب الغسل على مَن مسّ هذه الجثث أثناء عملية التشريح؟ وما حكم مَن نظر إلى عملية التشريح؟
ج: يجوز تشريح الجثث المذكورة إذا كانت لغير المسلمين. كما يجوز النظر إلى عملية التشريح، ويجب غسل المسّ بسبب مسّها.
س ٧٨: هل يجوز استعمال جسد الميت في التشريح لغرض الدراسة؟
ج: يحرم تشريح جسد الميت المسلم حتى لغرض الدراسة، وأمّا غير المسلم فيجوز ذلك فيه.
س ٧٩: هل يجب الغسل عند مس عضو ميت أثناء عملية التشريح؟ أرجو توضيح ذلك؟
ج: إذا كان العضو الممسوس يحتوي على العظم فاللازم الغسل بمسّه وإلاّ فلا يجب. هذا إذا كان الممسوس منفصلاً عن الجثّة، أمّا مع اتصاله بها فيجب غسل المسّ مطلقاً.
س ٨٠: إنّي طبيب أخصّائي وعملي يحتاج إلى لمس جمجمة الميت باستمرار، وهنا يتعذّر عليّ ارتداء الكفوف؛ وذلك لأنّها تمنع عني حاسّة اللمس، واللمس مباشرة مهم مع العلم أنّ الجماجم المتوفّرة لدينا أغلبها أجنبية أو لموتى أشكّ في غسولها ( غسل الميت )، ويتعذّر عليَّ الغسل باستمرار. فهل يجوز لمسها دون الغسل أو أستطيع أن أغسلها بنفسي (غسل الميت) كي تصبح طاهرة أم ماذا أفعل؟
ج: إذا كانت الجمجمة لمسلم لم يجز استخدامها لغرض الدراسة والتجربة، بل يجب دفنها.
وأمّا إذا كانت لكافر لم يجب الغسل بمسّها إذا كانت عظماً مجرّداً.
س ٨١: كما أنّني بحاجة إلى اقتناء جمجمة للدراسة عليها خارج
المستشفى، فهل يجوز أن أتملّك واحدة، بأن أشتريها من السوق؟ وبعنوان أيّ شيء تكون هذه المعاملة إن صحّت؟
ج: إذا كانت للمسلم لم يجز التعامل عليها، ووجب دفنها بعد لفّها في خرقة على الأحوط وجوباً.
وأمّا إذا كانت لكافر فلا بأس بالتصرّف فيها وشرائها.
س ٨٢: هل يجوز تشريح الميت المسلم إذا وافق أولياؤه؟
ج: لا يجوز ذلك.
س ٨٣: في بعض الدول تشرّح جثّة الميت بعد موافقة الولي وتوقيعه، وإذا لم يوقّع لا تسلّم الجثة بل تبقى في البرادات، فهل يجوز له التوقيع أو لا وتبقى الجثّة بدون دفن؟
ج: إذا تعذّر الدفن بدون تشريح ولم يجد الانتظار جاز التوقيع من قبل الولي على التشريح.
س ٨٤: هل يجوز تشريح الجثّة لغرض معرفة سبب الوفاة؟ وهناك فرق بين تشريح المسلم والكافر؟
ج: لا يجوز تشريح المسلم لذلك، احتراماً له.
س ٨٥: لو توقّف حفظ حياة مسلم على تشريح بدن ميت مسلم ولم يمكن تشريح بدن غير المسلم ولا مشكوك الإسلام، ولم يكن هناك طريق آخر لحفظه هل يجوز ذلك؟
ج: نعم يجوز، بل يجب. نعم تثبت ديّة الميت على المباشر على الأحوط وجوباً.
س ٨٦: هل يجوز قطع عضو من أعضاء إنسان حي للتشريح إذا رضي به؟
ج: لا يجوز ذلك على الأحوط وجوباً إلاّ مع توقّف مصلحة مهمّة عليه.
الموت الدماغي
س ٨٧: في حالة احتياج مريض لا يُرجى برؤه إلى جهاز التنفّس الصناعي بحيث يكون استمرارية نبض القلب متوقّفة على هذا الجهاز، وعلى عقاقير تزيد في الضغط ودقّات القلب، كما أنّه وصل إلى حالة ما يُعبّر عنها بـ ( الموت الدماغي ) فلا إحساس ولا حركة تصدر منه، وتأكّد ذلك بالتخطيط الدماغي الذي أظهر أنّه لا توجد ومضات كهربائية تصدر من الدماغ. ففي هذه الحالة هل يجوز إيقاف الأجهزة والعقاقير عنه؟
ج: إذا كانت الأجهزة والإسعافات هي المبقية لحركة القلب وجريان الدورة الدموية جاز قطعها، وإذا كانت مساعدة على بقائها مع وجود بقيّة للحياة الذاتية فلا يجوز قطعها، ومع الشك في تشخيص إحدى الحالتين يُبنى على الثانية.
س ٨٨: وكذا الحال، إذ استمرار العلاج يكون مكلفاً - تكاليف باهضة - لا يستطيع الورثة تحمّل أعبائها، علماً بأنّ
هذه الحالات لا يرجى منها أن تتحسّن أو يُكتب لها الاستمرارية في الحياة بحسب خبرة الأطبّاء. فهل يجوز عدم مباشرة العلاج بالأجهزة والعقاقير؛ لأنّه لن يستفيد المريض إلاّ أن تطول معاناته وذويه؟
ج: في الحالة الأُولى من الحالتين المتقدّمتين لا يجب الاستمرار في العلاج، حتى لو لم يكن مجحفاً بمال المريض أو بمال أهله.
وفي الحالة الثانية يجب الاستمرار فيه، حتى لو كان مجحفاً بهم. بل لو عجزوا وجب على الناس كفاية التعاون على استمرار العلاج.
س ٨٩: إذا تواجد جهاز واحد للتنفّس الصناعي واستُخدم لمريض لا يُرجى برؤه، وقد وصل إلى حالة الموت الدماغي، ثم احتاج مريض آخر يُرجى له الشفاء والبرء وكانت حياته متوقّفة على استخدام جهاز التنفّس، فهل يجوز في هذه الحالة أن نأخذ الجهاز من الميت دماغياً إلى المريض الآخر؟
ج: نعم يجوز، بل يجب مع كون المريض الثاني محترم الدم.
س ٩٠: هل نستطيع أن نجري أحكام
الميت على المريض الذي لا يُرجى برؤه وقد وصل إلى مرحلة الموت الدماغي - حيث لا إحساس ولا حركة ولا قدرة على التنفّس - واستمرّت هذه الحالة أكثر من ثلاثة أيام، وأكّد التخطيط الدماغي عدم وجود أي ومضات كهربائية تدل على وجود حياة، وكذا أكّد هذه الحالة فحص أكثر من طبيب مسلم؟
ج: في الحالة الأُولى يحكم بموت الشخص، وفي الحالة الثانية يحكم بحياته. ولابد في البناء على الحالة الأُولى من العلم بها ولو من طريق قول الأطبّاء.
س ٩١: في حالة الموت الدماغي وكان المريض تحت أجهزة الإنعاش الرئوي والقلبي، فهل يجوز فصل الأجهزة عنه، مع العلم أنّ القانون يوجب ذلك؟ وما الحكم بالنسبة للطبيب؟
ج: إذا كانت أجهزة الإنعاش هي التي تحرّك أجهزة البدن من دون أن تكون لها قابلية استمرار الحياة فيجوز فصل الأجهزة المذكورة. وأمّا إذا كانت أجهزة البدن تحمل شيئاً من بقايا الحياة
والأجهزة تساعدها على استمرار الحياة فيحرم فصل الأجهزة.
وقد طرحنا المسألة المذكورة مع بعض أهل الاختصاص؛ فأقرّ الاحتمال الأوّل في مفروض السؤال.
س ٩٢: بالنسبة للميت دماغياً، هل يجوز التبرّع بأعضائه لمرضى في أشدّ الحاجة إليها، وذلك في الحالات التالية:
أ - إذا مات الشخص دماغياً وأراد ذلك قبل موته وكتب ذلك بخط يده، سواء رضي أهله أم رفضوا؟
ب - إذا أراد ذلك أهل الميت بقصد الكسب المادي، ولن يعلم ما إذا كان الميت دماغياً راضياً بذلك أم لا؟
ج - في حالة تصرّف الطبيب بذلك دون علم أهل الميت؟
ج: لا يجوز نقل الأعضاء من الميت المسلم إلى الحي حتى لو أوصى بذلك، إلاّ إذا توقّف عليها حياة المسلم الحي، وحينئذٍ لا يحتاج إلى وصيّة الميت ولا إلى رضا أهله.
نعم إذا أمكن سدّ الحاجة بالأخذ من شخصين أحدهما قد أوصى أو رضي أهله، والآخر ليس كذلك، فالأحوط وجوباً ترجيح الأوّل.
ترقيع الأعضاء وبيعها
س ٩٣: هل يجوز أخذ عضو من أعضاء الميت لزرعه وإنقاذ إنسان مؤمن به؟ وهل هناك فرق بين إذنه ووصيّته بذلك قبل وفاته أو عدم إذنه؟
ج: إذا انحصر الأمر بالميت المذكور جاز الأخذ منه سواء أوصى أم لا، وسواء رضي وليّه أم لا. نعم يستحق الديّة بذلك.
س ٩٤: هل يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحو ذلك لإلحاقه ببدن الحي، مع تسليم الديّة؟
ج: يحرم ذلك، إلاّ أن تتوقّف حياة المسلم على العضو المذكور.
س ٩٥: وفي الفرض إذا قُطع وارتُكب هذا المحرّم هل يجوز الإلحاق بعده؟
ج: لا يجوز، بل يجب دفنه مع الميت.
س ٩٦: هل يجوز مع الإيصاء من الميت؟ وهل على القاطع الديّة؟
ج: لا يخلو عن إشكال، والأحوط وجوباً عدم الإقدام على ذلك.
س ٩٧: وفي الفرض إذا التحق والتحم ببدن الحي، هل يصبح جزءاً منه، وإذا كان العضو من بدن الكافر هل يحكم بالطهارة بعد الالتحاق؟
ج: إذا التحم وجرت فيه الحياة يعد جزءاً من بدن الحي ويلحقه حكمه.
نعم الأحوط وجوباً إذا كان من نجس العين أن تمرّ مدّة يُعدّ فيها جزءاً من بدن الحي عرفاً، كما ذكرنا ذلك في المسألة ( ٣٩٣ ) من كتاب الطهارة من رسالتنا ( منهاج الصالحين ).
س ٩٨: هل يجوز التبرّع بالكلية؟
ج: نعم يجوز لإنقاذ المؤمن إذا لم يتعرّض المأخوذ منه للخطر.
س ٩٩: هل تجوز زراعة كبد خنزير للمسلم؟
ج: نعم يجوز مع الحاجة، بحيث لا يمكن الاكتفاء عنه بطاهر العين قبل أن يصير من أجزائه عرفاً كما يظهر ممّا ذكرناه في المسألة ( ٤٠٩ ) من كتاب الطهارة من رسالتنا ( منهاج الصالحين ).
س ١٠٠: هل يجوز بيع الدم إذا كان
المشتري يستفيد منه؟
ج: نعم يجوز بيعه إذا كانت له فائدة محلّلة، ومنها التزريق في وريد مَن يحتاج إليه.
س ١٠١: هل يجوز بيع بويضات المرأة لأجل الاستفادة منها في تجارب طبّيّة؟
ج: نعم يجوز. لكن يحرم عليها كشف العورة إذا توقّفت عليه أخذ البويضات.
س ١٠٢: هل يجوز بيع الأعضاء، خاصة بالنسبة للفقير المحتاج للمال؟
ج: الأحوط وجوباً عدم بيع الأعضاء، خصوصاً ما كان معرضاً لأن تتوقّف عليه حياة الإنسان - كالكلية - بل إذا خشي الضرر بقلعه ضرراً تتعرّض معه الحياة للخطر فهو حرام.
س ١٠٣: هل يجوز أخذ الأموال بعنوان الهبة والهدية من الناس الذين يتاجرون ببيع وشراء بعض أجزاء جسم الإنسان مثل ( الكلية وغيرها ).
ج: لا بأس بأخذ المال منهم.
مرض الإيدز
حدّد الأطبّاء طرق العدوى الرئيسة لمرض الإيدز بما يأتي:
أ - طريق الاتصال الجنسي بين أفراد الجنس الواحد أو الجنسين، وهذا يمثّل أخطر الطرق وأكثرها شيوعاً، وتصل نسبة الإصابة عن هذا الطريق إلى ٨٠%.
ب - الدخول إلى الدم سواء كان ينقله أم بالحقن بالإبر، وبخاصة المخدّرات، أم بالجروح النافذة، وزراعة الأعضاء، وحتى العمليات الجراحية، إذا لم تكن الأدوات معقّمة تعقيماً جيّداً.
ج - عن طريق الأُم المصابة إلى جنينها إمّا أثناء لحمل وإمّا أثناء الولادة.
وتشير الإحصائيات إلى أنّ جميع دول العالم بها إصابات، وأنّه لا يوجد شعب محصّن ضد هذا المرض، كما أنّ أعداد المصابين في زيادة مستمرّة، معظمها بين الذكور، كما أنّ من مضاعفات الإصابة بمرض الإيدز انتشار كثير من الأمراض التي كان العالم على وشك التخلّص منها كحالات السلّ الرئوي.
ونعرض أمام سماحتكم الاستفتاءات التالية راجين بيان الحكم الشرعي فيها:
س ١٠٤: ما هو حكم عزل المصاب بالإيدز؟ فهل يجب عليه أن يعزل نفسه؟ وهل يجب على أهله عزله؟
ج: لا يجب العزل إلاّ بالمقدار الذي يتوقّف عليه تجنّب العدوى وعدم انتقال المرض.
س ١٠٥: ما هو حكم تعمّد نقل العدوى؟
ج: يحرم نقل العدوى.
س ١٠٦: هل يجوز للمصاب بالإيدز أن يتزوّج من السليم؟
ج: يجوز الزواج ولكنّ المباشرة الجنسية محرّمة إذا كانت موجبة للعدوى.
س ١٠٧: ما حكم زواج حاملي فايروس الإيدز من بعضهم؟
ج: الزواج جائز والممارسة الجنسية أيضاً جائزة، إلاّ أن تزيد من ضرر المرض زيادة بالغة الأهمّية.
س ١٠٨: ما حكم المعاشرة الجنسية بالنسبة للمصاب بمرض الإيدز؟ وهل يحق لغير المصاب بالإيدز أن يمتنع
عن المعاشرة؛ لأنّها من الطرق الرئيسة للعدوى؟
ج: نعم يحق. لكن ينبغي الاهتمام بالجانب النفسي للمريض وعدم جرح شعوره بالمقدار الممكن.
س ١٠٩: ما حكم حقّ السليم من الزوجين في طلب الفرقة؟
ج: من حق الزوج أن يطلّق زوجته المصابة وغير المصابة، كما أنّ للزوجة الامتناع عن المعاشرة الجنسية الموجبة للعدوى وإن كانت تبقى لها باقي الحقوق.
س ١١٠: ما حكم الطلاق من المرأة إذا كان الزوج مصاباً بمرض الإيدز؟
ج: ليس من حقّ المرأة الطلاق. نعم لها حقّ الامتناع عن المعاشرة الجنسية المؤدّية للعدوى.
س ١١١: ما حكم إجهاض الحامل المصابة بمرض الإيدز؟
ج: حرام.
س ١١٢: ما حكم حضانة الأُم المصابة لوليدها السليم، وإرضاعه ( اللباء وغيره )؟
ج: يحرم على المرأة القيام بما يوجب نقل العدوى لوليدها السليم، ويجوز لها ما لا يوجب ذلك.
س ١١٣: ما حكم اعتبار مرض الإيدز مرض موت؟
ج: لا يترتّب على ذلك أثر شرعي على فتوانا.
س ١١٤: هل يجوز للطبيب أو يجب عليه أن يعلن عن الإصابة بمرض الإيدز لمَن يهمّهم أمر المريض كالزوجات أو الأزواج مثلاً؟
ج: يجب إعلام ذوي المريض إذا كان ذلك يمنع من إصابتهم بالمرض.
س ١١٥: لو علم مسلم أنّه مصاب بمرض الإيدز المعدي، فهل يجوز له ممارسة العمل الجنسي مع زوجته؟ وهل يجب عليه إعلامها بذلك؟
ج: يحرم عليه ممارسة الجنس معها إذا كانت الممارسة توجب انتقال المرض إليها.
الحجامة
كان من منن الباري سبحانه لنا أن تفضّل علينا ووفّقنا لجمع طائفة كبيرة من الأحاديث الشريفة، وفتاوى علمائنا الأبرار (رضوان الله على الماضين وأدام الله عمر الباقين) حول ( الحجامة ) تلك السُنّة الكريمة، والتي أصبحت مهجورة ومجهولة بل منبوذة. وكان لي التوفيق الأكبر في ما توصّلت إليه من نتائج باهرة، وآثار عجيبة خلال ممارستي لهذه السنّة الكريمة مدّة تزيد على اثني عشر سنة.
واليوم حيث تحيى هذه السنّة الإلهيّة من جديد ضمن تبنّي جمع كبير لها من الأطباء وأصحاب الاختصاص إذا طُرحت في المجاميع العلمية الطبّية كأحد الطرق المعتبرة في مقام العلاج، ونود أن نستعين بنظراتكم الفقهية الشريفة من خلال ما يهمّ المؤمنين عامة، ومقلّديكم خاصة من مسائل علمية تعرض للمكلّفين في هذا المقام، راجين أن تتفضّلوا علينا بالإجابة عليها مشكورين، وهي:
( أوّلاً ):
ما حكم الصلاة لمَن بقي على بدنه أثر الدم بعد الحجامة، وذلك:
س ١١٦: هل يصدق عنوان الجرح
على محل الحجامة؟
ج: نعم يصدق عليه عنوان الجرح وتترتّب آثاره الشرعية.
س ١١٧: هل يلزم التطهير لمحل الجرح مع احتمال عدم البرء وانقطاع الدم؟
ج: لا يجب التطهير حينئذٍ.
س ١١٨: هل يلزم التطهير لموضع الجرح مع احتمال الضرر.
ج: لا يجب التطهير حينئذٍ.
س ١١٩: ما حكم ما لو شك بأنّ التطهير يضر به أم لا، أو أنّ الجرح برء أم لا؟
ج: يحتاط بدفع الضرر بترك التطهير.
( ثانياً ):
ما حكم الحجامة في نهار الصيام، وذلك:
س ١٢٠: هل يلزم تأخيرها إلى الليل أو بعد شهر الصيام لو لزم منه الضعف لا بطلان الصيام؟
ج: تكره الحجامة نهاراً للصائم إذا خشي الضعف. ولا تحرم إلاّ
أن تؤدّي إلى العجز عن الصيام من دون ضرورة لها.
٢ - ما حكمه لو تعارض بطلان الصوم مع ضرورة الحجامة بنظر الطبيب المعالج، وكون التأخير موجباً للمرض، أو تشديد، أو بطؤ علاجه، وما حكمه لو كان الضرر بنظر الطبيب احتمالياً؟
ج: إذا أوجب قول الطبيب المعالج خوف الضرر كفى في جواز الحجامة. بل تجب إذا كان الضرر المخوف مهمّاً يخشى أن يؤدّي إلى الهلاك.
( ثالثاً ):
ما حكم حجامة المحرم؛ وذلك:
س ١٢١: لإقامة السنّة أو حفظ الصحّة أو غيرهما من الدواعي كالتوقّي من شدّة المرض؟
ج: لا تحل الحجامة للمحرم إلاّ مع الضرورة، لخوف الضرر من تركها.
س ١٢٢: ما حكمه لو كان لأجل الاستعلاج وكان بنظر الطبيب المعالج ضرورياً للعلاج، أو للتوقّي من شدّة المرض ولا يمكن تأخيره إلى بعد أيام الحج؟
ج: تحل الحجامة حينئذٍ إلاّ مع الاطمئنان بخطأ الطبيب.
س ١٢٣: ما حكم حلق موضع الحجامة أثناء الإحرام لو كان الحلق ضرورياً؟
ج: إذا كان الحلق ضرورياً حلّ، ولا يحل اختياراً.
( رابعاً ):
ما حكم أجرة الحجام، وذلك:
١ - هل يجوز للحجام أو المحتجم أن يشترط أجرة معيّنة، أو يطلق، أو ينصرف إلى المتعارف؟
ج: نعم يجوز لهما المشارطة. نعم هي مكروهة في حق الحجام، دون المحتجم أو مَن يقوم مقامه.
( خامساً ):
ما حكم عمل الحجام؟ وهل ينزل بمنزلة الطبيب لعدم الضمان فيما إذا لزم من عمله ضرراً على المحتجم من دون أن يكون تقصيراً منه؟ وما حكمه ما لو كان قاصراً في ذلك؟
ج: لا ضمان على الحجام إذا كان مأذوناً في الحجامة وترتّب الضرر على الحجامة بنفسها، أمّا إذا ترتّب الضرر على خصوصياتها غير المأذون فيها - كاستعمال الآلة الخاصة، أو أخذ المقدار الخاص من الدم - من دون أن يكون أصل الحجامة مضرّاً فهو ضامن، إلاّ أن
يأخذ براءة من الضمان من المحتجم أو من وليّه. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
ونسأل الله جلّت آلاؤه وعظمت نعماؤه أن يمدّكم بالتوفيق والتأييد، وأن يسدّدكم في مسيرتكم في إحياء هذه السنّة الشريفة والتعرّف على حدودها وفوائدها في سبيل الانتفاع بها وجني ثمراتها. وقد سرّنا مشروعكم هذا بعد أن أُسدل الستار عن الحجامة نتيجة ظهور مدرسة الطب الحديثة التي يبدو أنّها لا تعرف شيئاً عنها، وكم تحدّثنا مع الأطبّاء المعاصرين من أجل التعرّف على حدودها وآثارها أملاً في الانتفاع بها فرأيناها غريبة عليهم، ولم نحصل منهم على شيء. والأمل منكم المضي في مشروعكم هذا وتطويره، وفتح أبواب المعرفة في بقيّة السنن والإرشادات التي تضمّنتها أحاديث المعصومين (صلوات الله عليهم أجمعين). مع حسن النيّة مع الله تعالى وصدق التوكّل عليه، إنّه وليّ المؤمنين.
والسلام عليكم وعلى العاملين معكم ورحمة الله وبركاته.
أُمور طبّيّة متفرّقة
س ١٢٥: الطبيب الجرّاح هل يضمن إذا لم تنجح العملية الجراحية من دون تقصير أو مسامحة منه؟ وهل يعتبر جري الناس على عدم الضمان شرطاً ضمنياً مسقطاً لضمانه؟
ج: يضمن الطبيب الجرّاح مع التقصير، وكذا مع عدم التقصير، إلاّ بأخذ البراءة من المريض أو وليّه وإن كان قاصراً ولو لفقده الشعور حين إجراء العملية. ولا يكفي جري الناس على عدم الضمان في البراءة إذا لم يبتن إقدام المريض أو وليّه على ذلك، بل لابد فيها من إقدام المريض أو وليّه على البراءة، ولو لكونها شرطاً ضمنياً ارتكازياً عند الطرفين، مستفاداً من الواقع القائم.
س ١٢٦: مريض راجع طبيباً وأعطاه وصفة دواء وعرضها على الصيدلي، ولكنّ الصيدلي أعطاه دواءً آخر غير المقصود بسبب الإهمال وتوفّي المريض بسبب هذا الخطأ، فهل يستحق أهل المريض المتوفّي الديّة؟ وهل يدخل هذا الإهمال في قتل الخطأ أو قتل العمد؟
ج: إذا رجع الإهمال للتفريط كان عليه الديّة، بأن كان متسامحاً في دفع الدواء القاتل. أمّا مجرّد الخطأ من دون تسامح فلا ضمان معه.
س ١٢٧: إذا وضعت البيضة المخصبة في الحاضنة الصناعية وماتت، فعلى مَن تكون الديّة؟
ج: لا ديّة، إلاّ أن تلج الروح فتكون الديّة على مَن يستند القتل له.
س ١٢٨: الجنين من الحرام عند إسقاطه من قِبَل الطبيب بإذن أهله على مَن تجب ديّته؟
ج: تجب الديّة على المباشر للإسقاط كالطبيب إذا كان بعملية إجهاض، والمرأة إذا شربت الدواء أو تحرّكت حركة عنيفة حتى أسقطت أو نحو ذلك.
س ١٢٩: لو قامت امرأة بإجهاض حمل امرأة أُخرى مع كون هذه راضية بالإجهاض، أو هي طلبت من تلك أن تجهض الحمل فعلى مَن تكون الديّة؟
ج: تكون الديّة على التي قامت بالإجهاض، دون الراضية به، وإن كانتا مشتركتين في المعصية.
س ١٣٠: في حالة التوأم الملتصق
بعضهما مع البعض. هل يجوز التضحية بأحدهما على حساب إنقاذ حياة الآخر؟
ج: إذا كان بقاؤهما ملتصقين يؤدّي إلى وفاتهما معاً وجبت التضحية بأحدهما من أجل إنقاذ الآخر، وإلاّ حرم.
س ١٣١: توجد في مختبرات المستشفيات أجنّة موضوعة في أوعية تحتوي على مواد حافظة - مادة الفورمالين - عمرها لا يزيد عن أربعة أشهر؟
أ - ما رأي الشرع في ذلك علماً بأنّه لا فائدة من وجودها؟
ب - ما الحكم في لمس هذه الأجنّة إن كان في مجال العمل أو خارج مجال العمل؟
ج - هل يجوز وضعها في المختبرات عند أخذ أمر أولياء هذه الأجنّة؟
ج: أ - يجوز ذلك إذا كان جنيناً لغير مسلم، وأمّا إذا كان لمسلم فيحرم تركه من غير دفن، بل يجب دفنه ومواراته.
كما أنّ الأحوط وجوباً عدم تأخيره مدّة معتدّاً بها من دون حاجة
عرفية للتأخير، وأمّا جريان باقي أحكام التجهيز ففيه تفصيل مذكور في رسالتنا العملية ( منهاج الصالحين ).
ب - يجب الغسل بمسّها إذا كانت الروح قد ولجتها.
ج - ليس للولي أن يُحلّ في أمر الجنين ما هو محرم.
س ١٣٢: يوجد في مختبرات المستشفيات قسم يسمّى بنك الدم، ويقوم هذا القسم بأخذ دم المتبرّعين، وبعض الأشخاص يأتون إلى هذا القسم - عن طريق جهة معيّنة - مثلاً للحصول على رخصة للقيادة، وبعضهم لا يرغبون في التبرّع ولكن يجبرون على التبرّع؛ لكي يحصلوا على تصريح من المستشفى إلى الجهة المرسل منها؟
أ - ما حكم الدم المأخوذ من الأشخاص الغير راغبين في التبرّع؟
ب - ماذا على الموظّف الذي يقوم بعملية السحب؟
ج - ماذا على الشخص الذي نُقل إليه الدم إذا كان محتاجاً للدم مع علمه أو عدمه بأنّ هذا الدم
من شخص أُرغم على التبرّع؟
ج: أ - يحرم التصرّف به إلاّ برضاهم ولو من باب الرضا بالتصرّف بالدم بعد أخذه منه.
ب - يجوز للموظّف القيام بذلك بعد إقدام صاحب الدم عليه ورضاه به ولو من أجل تحصيل الرخصة.
ج - يحرم عليه أخذ الدم إذا لم يحرز رضا صاحبه إلاّ أن يحتاج إليه لدفع الخطر على صحّته فيجوز له. لكن يكون ضامناً لثمنه لصاحبه، ومع الجهل به يجري عليه حكم مجهول المالك.
س ١٣٣: ما حكم تناول الأدوية من قِبَل المريض وهي تحتوي على الكحول؟
ج: لا يجوز تناولها إلاّ مع الضرورة الملحّة البالغة مورد الخطر ومع انحصار الأمر بها.
س ١٣٤: هل يجوز للطبيب أن يصرف دواءً للمريض لا يحتاجه واقعاً:
١ - بل لأجل إرضاء ميول المريض أو رغبته؟
ج: إذا كان الدواء مضرّاً بالمريض ضرراً لا يجوز تحمّله لم يجز صرفه بحال، وإن لم يكن كذلك فيجوز صرفه بعد إعلام المريض بعدم
حاجته له.
٢ - أو لأجل تصريف الدواء وإن كانت الوصفة لا ضرر لها، أو نافعة ولكن لا حاجة فيها للمريض؟
ج: تصريف الدواء ليس من المبرّرات في الخروج عن الأمانة المفروضة في الطبيب.
٣ - أو لأجل المحافظة على سمعة المستشفى أو الطبيب؛ لأنّ طبيباً لا يعطي الدواء ليس بطبيب حاذق في ذهن العوام من الناس؟
ج: الحال فيها كالسابق.
س ١٣٥: هل يجوز للطبيب إخبار المريض أو أهله بالحالة الصحّية للمريض، حتى ولو كانت خطرة جداً ممّا يؤثّر سلباً على الحالة النفسية للمريض؟
ج: لا يجوز إخبار المريض في الحالة المذكورة، إلاّ إذا توقّف عليه شفاؤه، بأن كان ممتنعاً عن العلاج بسبب جهله بخطورة حالته.
س ١٣٦: بالنسبة للمرضى المبتلين
بالصرع وفي اعتقادهم أنّ ذلك ليس مرضاً وإنّما هو مسّ الجن، فهل على الطبيب أن يقرّهم على اعتقادهم ذلك. وهل هذا الاعتقاد صحيح أم لا؟
ج: لا يجب تصحيح الاعتقاد المذكور، وهذا الأمر ممكن في نفسه.
الفهرس
الاستنساخ البشري ٥
تقديم بقلم: د. أبو حسين المصري ٧
تجميد الحيامن والتلقيح الصناعي ٣١
طفل الأنابيب ٥٣
اللولب وموانع الحمل ٦٩
الإجهاض ٧٩
التّشريح ٨٧
الموت الدماغي ٩٣
ترقيع الأعضاء وبيعها ٩٩
مرض الإيدز ١٠٥
الحجامة ١١١
أُمور طبّيّة متفرّقة ١١٩