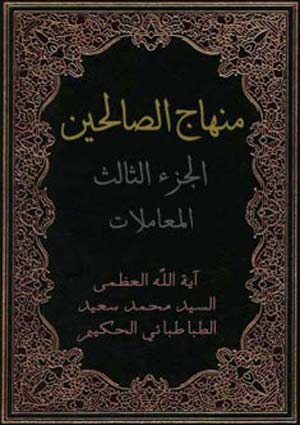منهاج الصالحين
الجزء الثالث
المعاملات
السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب النكاح
كتاب النكاح
وهو رباط شريف شرعه الله تعالى رحمة بعباده، لبقاء النوع الانساني وتنظيم الغرائز التي أودعها فيه، حفاظاً على عفة الانسان ودينه، وأنساً لوحشته، ووصلاً لوحدته ونظماً لحياته. قال تعالى:( والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ) ، وقال عز اسمه:( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة إنّ في ذلك لايات لقوم يتفكّرون ) .
وقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «من تزوج أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الباقي». وقال الامام الباقر (عليه السلام): «ما أفاد عبد فائدة خيراً من زوجة صالحة إذا رآها سرته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله».
وهو من المستحبات المؤكدة بل يكره تركه. قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «ما بني بناء في الاسلام أحب إلى الله عزوجل من التزويج»، وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «من أحب أن يكون على فطرتي فليستن بسنتي وإن من سنتي النكاح»، وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «من أحب أن يلقى الله طاهراً مطهراً فليلقه بزوجة».
وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «ركعتان يصليهما متزوج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله ويصوم نهاره». وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «رذال موتاكم العزاب»، والنصوص في ذلك ونحوه لا تحصى كثرة.
وقد تضمن جملة منها النهي عن ترك الزواج خوف الفقر، وأن من فعل ذلك فقد ساء ظنه بالله تعالى. بل ورد فيها أن الزواج من أسباب الرزق، وأن الرزق مع النساء والعيال... إلى غير ذلك. فعلى المؤمنين وفقهم الله تعالى الاهتمام بتسهيل أمر الزواج بتخفيف قيوده وتقليل نفقاته والتعاون عليه، إقامة للسنة ودفعاً للفساد والفتنة.
ومن عجز عن الزواج فعليه أن يدّرع التقوى والصبر، ويبعد نفسه عن مواقع المعصية والفتنة، ويحذر من كيد الشيطان وغروره، ويكبح جماح النفس الامّارة بالسوء، ويتحلى بالعفة والفضيلة، ويربأ بنفسه عن السقوط في
مهاوي الخسة والرذيلة متمسكاً بوصية الله تعالى له، حيث يقول: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتّى يغنيهم الله من فضله). وقد ورد عنهم (عليهم السلام): أنه يستحب الاستعانة على العزوبية بالصيام وتوفير الشعر، وأن بهما تخف حدة الحاجة للنكاح.
ونسأله سبحانه أن يعين شباب المؤمنين في بليتهم، ويعصمهم في محنتهم ويزيدهم إيماناً وتسليماً (ومن يتقِ الله يجعل له مخرجاً * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكَّل على الله فهو حسبه إنَّ الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر).
وينبغي - مقدمة للكلام في المقام - التعرض لحكم العلاقة بين الجنسين، وبين أفراد الجنس الواحد، مع قطع النظر عن الزواج، ثم الكلام في النكاح في فصول تتضمن آدابه وأركانه وأقسامه وشروطه وأحكامه ونحوه.
مقدّمة في العلاقة بين الجنسين
وبين أفراد الجنس الواحد
(مسألة ١): يحرم على الرجل والمرأة التلذذ الجنسي بغير الزوجة والزوج ونحوهم، سواءً كان مماثل، كالرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، أم مخالفاً محرماً أو غير محرم. بل الظاهر عدم جواز التلذذ المذكور بغير الانسان، كالبهائم والتماثيل المجسمة والصور غير المجسمة.
(مسألة ٢): لا فرق في حرمة التلذذ المذكور بين أن يكون باللمس والتقبيل والنظر والسماع، كما لا فرق بين أن يكون بقصد الانزال وغيره.
(مسألة ٣): إذا كانت الاُمور المذكورة مبنية على الاعجاب بجمال المنظور أو الملموس أو المسموع من دون أن تصل إلى التلذذ الجنسي فلا تحرم، لكن ينبغي الحذر من الوصول إلى التلذذ الجنسي، فالاولى التجنب حذراً من الوقوع فيه. هذا كله في المماثل وأما في غيره فيلحقه ما يأتي.
(مسألة ٤): يحرم على الانسان - رجلاً كان أو امرأة - التلذذ بمس عضوه الجنسي، ببعض جسده أو بغيره، وإن لم يبلغ حد الانزال، فضلاً عما إذا بلغ ذلك. بل الأحوط وجوباً العموم للتلذذ بالنظر. نعم يستثنى من ذلك العبث بالعضو الجنسي للاستعانة على الوطء المحلل واستكمالاً للتلذذ به من دون أن يبلغ حد الانزال.
(مسألة ٥): يجب على المرأة ستر جميع جسدها وشعرها عن غير المحرم من الرجال عدا الوجه والكفين. وأما القدمان فالأحوط وجوباً سترهم. نعم
إذا قعدت عن النكاح جاز لها أن تكشف رأسها وذراعيها من دون زينة غير ما يأتي، وإن كان الافضل لها ستر ذلك.
(مسألة ٦): يجوز للمرأة التزين في الموضع الذي يحل كشفه من بدنها بالكحل والخاتم والسوار، ولا يحل ما زاد على ذلك كالمكياج المتعارف في عصورن. نعم يحل على كراهة زينة الثياب الظاهرة، سواءً كانت بمثل التلوين والتطريز أم بكيفية الخياطة والتفصيل، إلا ما كان مظنة الاثارة والفتنة فالأحوط وجوباً تجنبه. كما أن الأحوط وجوباً لها عدم استعمال الطيب بحيث يشمه الاجنبي.
(مسألة ٧): لا يجب التستر عن غير ذي الاربة من الرجال، وهو الذي لا رغبة له في النساء. والأحوط وجوباً الاقتصار على من استمر على ذلك من طفولته لنقص في إدراكه ولبلاهته، دون مثل الشيخ والمريض.
(مسألة ٨): لا يجب على المرأة التستر عن المحارم، وهم الذين يحرم نكاحهم لها بالنسب أو الرضاع المحرِّم كالاب والولد والاخ والعم. وكذا المحارم بالسبب، وهم الذين يحرم نكاحهم لها مؤبداً بسبب عقد النكاح الصحيح، كأب الزوج وابنه وزوج البنت وزوج الاُم المدخول به، أو بسبب وطء مشروع كموطوءة الاب والابن بالملك. دون ما يحرم بسبب عقد نكاح غير مشروع كنكاح ذات البعل أو في العدة أو بسبب وطء محرم كاللواط بالاخ، أو بسبب آخر كالطلاق تسع، فضلاً عما يحرم مؤقتاً كالمطلقة ثلاثاً وبنت الزوجة غير المدخول بها واُخت الزوجة.
(مسألة ٩): يستثنى من جواز التكشف للمحارم ومن جواز النظر إليهم العورة على ما تقدم في أحكام التخلي من كتاب الطهارة. كما أن الأحوط وجوباً ترك ما كان مظنة الاثارة والفتنة من التخلع والتزين، نظير ما تقدم في غير المحارم.
(مسألة ١٠): يحرم على الرجل النظر لما يجب ستره من جسد المرأة، إل
أن تكون متكشفة بحيث إذا نهيت لا تنتهي ولا تتستر، من دون فرق في ذلك بين كون تكشفها لاعتقاد الحل وأن يكون تسامحاً وعصيان. أما إذا كان تكشفها غفلة عن وجود الناظر بحيث لو نبهت لاستترت فلا يجوز النظر إليها إذا كانت مسلمة، بل حتى إذا كانت كافرة على الأحوط وجوب.
(مسألة ١١): الأحوط وجوباً عموم وجوب الستر وحرمة النظر لصورة المرأة في المرآة ونحوها مما يحكي حكاية تامة، بل الأحوط وجوباً العموم لمثل الماء الصافي مما يحكي حكاية ناقصة، إلا أن لا تتميز الصورة حينئذٍٍ، بل تكون شبحاً لا غير. وأما الصورة التلفزيونية والفتوغرافية ونحوهما فالظاهر جواز النظر إليه، وإن كان الأحوط استحباباً تركه إذا لم تتعمد المرأة بذل الصورة. بل يحرم إذا كانت مؤمنة وكان النظر هتكاً لها وتوهيناً عرف، كما قد يكون ذلك فيما إذا كانت مصونة في نفسها وكانت الصورة معرفة له.
(مسألة ١٢): يجوز نظر المرأة للرجل الاجنبي، والأحوط وجوباً أن لا تملأ نظرها منه وتتأمله.
(مسألة ١٣): يحرم على كل من الرجل والمرأة الاجنبيين مس أحدهما الآخر، من دون فرق بين ما يحل النظر له من المرأة وغيره، فلا يجوز لهما المصافحة. ولا يسوّغ ذلك كونه في بعض الاوساط والاعراف البعيدة عن الدين من جملة آداب المعاشرة، بحيث يُرمى تاركه بسوء الخلق ومجانبة الادب، فإن في الجري على تلك الاعراف في مثل ذلك تضييعاً لتعاليم الدين وطمساً لمعالمه وانصهاراً بتقاليد الكفر وتبعية له، بل يلزم الاصرار على تطبيق الحكم الشرعي والعمل عليه بلطف ووداعة وأدب، حتى يشيع ويعرف حاله على حقيقته، ويصير التزام المسلم به علامة على قوة شخصيته وتمسكه بدينه واعتزازه بمبدئه، وتسامحه فيه علامة على ضعف شخصيته وتحلله.
(مسألة ١٤): الظاهر عدم وجوب ستر الشعر والجزء المفصولين من
المرأة عن الرجل وجواز نظره إليه. نعم إذا كانت المرأة الميتة مقطعة الاعضاء فالأحوط وجوباً عدم النظر إلى أعضائها المعتد بها المقومة لجسدها عرف، بل إذا صدق على النظر إليها النظر للمرأة الميتة فالظاهر حرمته.
(مسألة ١٥): إذا اضطر للنظر المحرم لعلاج أونحوه، فإن أمكن الاكتفاء بالنظر للصورة المنعكسة في المرآة تعين، وإلا حلّ النظر للجسد بنفسه، ويقتصر على مورد الاضطرار من حيثية المقدار المنظور إليه ومدة النظر وزمانه. وهكذا الحال في المس.
(مسألة ١٦): ليس من الاضطرار المسوغ للنظر والمس المحرمين الاختلاط العائلي، لاجتماع العوائل في بيت واحد، أو لتآلفها وكثرة الاجتماع والتزاور بينه. وما تعارف - نتيجة لذلك - من التسامح في الحجاب والنظر بين الرجل وزوجة أخيه أو اُخت زوجته أو بنت عمه أو نحوهم من الاقارب بل الاصدقاء لا مسوغ له. ومن الغريب تعارف ذلك بين بعض العوائل المحترمة والمعروفة بالتدين والالتزام والاحتشام. والانكى من ذلك والامض رفع الحواجز في مناسبات الافراح والاعراس حيث يستخف الفرح أهله فيدخل الشباب وهم في أوج حيويتهم ونشاطهم على النساء المتبرجات بملابسهن الفاضحة وزينتهن الصارخة على أتم الوجوه وأدعاها للفتنة والاثارة، تغاضياً عن مقتضيات الغيرة والعفة، وخروجاً عن قوانين الشرع الشريف، ونبذاً لتعاليم الدين الحنيف، كفراً لنعمة الله تعالى بمعصيته وانتهاك حرمته وتعدي حدوده في موقف هو أدعى لشكره تعالى بطاعته والخضوع لارادته والوقوف عند أمره ونهيه، استيجاباً لرحمته واستزادة من نعمته كما قال جلت أسماؤه وعظمت آلاؤه: (لئن شكرتم لازيدنّكم ولئن كفرتم إنَّ عذابي لشديد).
(مسألة ١٧): يجوز للرجل سماع صوت المرأة الاجنبية، وللمرأة سماع
صوت الرجل الاجنبي. نعم لابد من عدم التلذذ الجنسي بذلك كما تقدم.
(مسألة ١٨): يكره للرجل النظر لادبار النساء.
(مسألة ١٩): يكره اختلاط الرجال بالنساء الاجنبيات، وفي حديث سيدة النساء J قالت: «خير للنساء أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال» بل قد يحرم إذا كان مظنة للفتنة والفساد، خصوصاً ما يبتني منه على التزاحم والتضام.
(مسألة ٢٠): يكره للرجل الجلوس في مكان المرأة إذا قامت عنه حتى يبرد.
الفصل الاول
في آداب النكاح وسننه وما يناسب ذلك
(مسألة ٢١): يستحب للرجل عند إرادة التزويج أن يصلي ركعتين ويحمد الله تعالى ويقول: «اللهم إني اُريد أن أتزوج، اللهم فقدّر لي من النساء أعفهن فرجاً وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي وأوسعهن رزقاً وأعظمهن بركة، وأقدر لي منها ولداً طيباً تجعله خلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتى».
(مسألة ٢٢): يجوز للرجل النظر للمرأة التي يريد الزواج منه، والأحوط وجوباً الاقتصار على ما يتعارف كشفه عند لبس ثياب البيت كالعضدين والساقين والرأس وقسم من الصدر، دون ما يتعارف ستره بالثياب، ولا بأس بترقيق الثياب وكونها بحيث تحكي حجم البدن. نعم لابد من الاقتصار على ما يعرف به حالها وعدم الاستزادة من النظر عن قدر الحاجة.
(مسألة ٢٣): يستحب اختيار البكر الجميلة الطيبة الريح الطيبة الطبخ الضحوك العفيفة الهينة اللينة الودود الكريمة الاصل ذات الدين والخلق والتي تعين زوجها وتحفظه في غيبته. وفي الحديث: «إنما المرأة قلادة فانظر ما تتقلد».
(مسألة ٢٤): يكره اختيار المرأة لمالها وجماله، فعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «من تزوج امرأة لمالها وكله الله إليه، ومن تزوجها لجمالها رأى فيها ما يكره، ومن تزوجها لدينها جمع الله له ذلك». كما يكره تزوج المرأة الحسناء السيئة الاصل، وقد شبهها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالنبتة الخضراء في المزبلة. ويكره تزوّج الحمقاء، وقد ورد أن الاحمق قد ينجب والحمقاء لا تنجب.
(مسألة ٢٥): يستحب اختيار المرأة الولود ويكره تزوّج العقيمة وإن كانت جميلة.
(مسألة ٢٦): يستحب الاشهاد على العقد والاعلان به، والخطبة أمام العقد، وأقلها حمد الله تعالى. كما يستحب الوليمة فيه نهاراً يوماً أو يومين، ويكره ما زاد على ذلك.
(مسألة ٢٧): يستحب زف المرأة وإدخالها على زوجها ليل. ويستحب للزوج صلاة ركعتين عند ذلك وأن يدعو بالمأثور وقد ورد عدة صور لذلك، ومنها أن يأخذ بناصيتها مستقبل القبلة ويقول: اللهم بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللته، فإن قضيت لي منها ولداً فاجعله مباركاً تقياً من شيعة آل محمد، ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيب». وقد ورد عن الامام الباقر (عليه السلام) لجلب الالفة بين الزوجين قال: «إذا دخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة، ثم أنت لا تصل إليها حتى تتوضأ وتصلي ركعتين ثم مرهم أن يأمروها أن تصلي أيضاً ركعتين، ثم مجّد الله وصل على محمد وآل محمد، ثم ادع الله ومر من معها أن يؤمّنوا على دعائك. وقل: «اللهم ارزقني إلفها وودها ورضاها ورضني به، ثم اجمع بيننا بأحسن اجتماع وأسر ائتلاف، فإنك تحب الحلال وتكره الحرام».
(مسألة ٢٨): يكره دخول الرجل بالمرأة ليلة الاربعاء.
(مسألة ٢٩): أكد الاسلام على لسان نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) والائمة من أهل بيته (عليهم السلام) على نبذ فوارق النسب في النكاح وأن المؤمن كفء المؤمنة. كما أكد على أنه ينبغي الاهتمام بالدين والخلق والامانة والعفة، وقد ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعنهم (عليهم السلام) في نصوص كثيرة: «إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير ». فلا ينبغي رد الخاطب المؤمن إذا كان متديناً حسن الخلق، خصوصاً إذا كان ذا يسار، بحيث ينهض بمعاشه ومعاش عياله. وأما ما تعارف عند بعض القبائل من عدم تزويج بناتهم لغيرهم اعتزازاً بأنفسهم وترفعاً وتعالياً عن غيرهم أو قصر بناتهم على فئة خاصة من الناس فهو استجابة لدعوة الشيطان للعصبية الجاهلية، مع ما يترتب على ذلك من تعطيل النساء وحرمانهن من أهم حقوقهن، فإن صبرن ظلمن ظلم من لا يجد ناصراً إلا الله تعالى وهو أفحش الظلم، وإن خرجن عن ذلك فهو الجريمة والاثم منهن ومن القبيلة والعار والشنار عليهن وعليه، ثم ردود الفعل الظالمة التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان: (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون).
(مسألة ٣٠): ما تعارف عند كثير من المؤمنين من عدم الاستجابة لتزويج الخاطب الذي يرتضونه إلا بعد الاستخارة بالوجه المتعارف في زمانن، ليس له أساس شرعي، ولا يناسب النصوص المشار إليها آنف. نعم يحسن في الزواج وفي جميع الاُمور الاستخارة بمعنى طلب الخيرة من الله تعالى بالوجه المتقدم في مبحث صلاة الاستخارة من الصلوات المستحبة.
(مسألة ٣١): يكره تزويج شارب الخمر وسيّئ الخلق والمخنث، بل كل من ليس له التزام ديني. وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «النكاح رق، فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقه، فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته».
(مسألة ٣٢): يكره للمرأة تعطيل نفسها عن الزواج، وعن الزينة لزوجها وإن كانت مسنة.
(مسألة ٣٣): يستحب تعجيل زواج البنت، وعن الامام الصادق (عليه السلام) أنه قال: «من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته». بل يكره تأخيرها إذا أدركت وحاضت.
(مسألة ٣٤): يكره إيقاع عقد الزواج إذا كان القمر في برج العقرب، كما يكره في محاق الشهر، وهو آخره عند عدم ظهور القمر ودخوله في شعاع الشمس.
(مسألة ٣٥): يكره الجماع ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، وحين اصفرار الشمس عند طلوعها وغروبه، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفي الليلة التي ينخسف فيها القمر، وفي الليلة وفي اليوم اللذين يكون فيهما الزلزلة، وخصوصاً حال الزلزلة، وفي حال هياج الريح السوداء والصفراء والحمراء، وفي محاق الشهر. ويكره الجماع أيضاً في أول ليلة من الشهر الهلالي وليلة النصف منه، ويستثنى من ذلك أول ليلة من شهر رمضان المبارك، فقد ورد في بعض الروايات استحباب الجماع فيه.
(مسألة ٣٦): يكره الجماع مستقبل القبلة ومستدبره، وفي السفينة، وعلى ظهر طريق عامر، وتحت السماء.
(مسألة ٣٧): يكره الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل منه، وحين الاختضاب قبل أن يأخذ الخضاب مأخذه.
(مسألة ٣٨): يكره الجماع عاري، ومن قيام. كما يكره الكلام حال الجماع بغير ذكر الله تعالى، ولبس خاتم فيه ذكر الله تعالى أو شيء من القرآن.
(مسألة ٣٩): يكره نظر الزوج لفرج امرأته خصوصاً حال الجماع.
(مسألة ٤٠): يستحب التستر بالجماع، ويكره الجماع في بيت فيه أحد
يصف حالهما ويسمع نفسهما وإن كان صبي. وتستحب التسمية عند الجماع والاستعاذة من الشيطان، والدعاء بالمأثور، ومنه أن يقول: «بسم الله وبالله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني».
(مسألة ٤١): يستحب أن يختص كل من الرجل والمرأة بخرقة للتمسح بها بعد الجماع، ويكره اشتراكهما بخرقة واحدة يتمسحان بها مع، وفي النصوص أن ذلك من أسباب النفرة والبغضاء بينهم.
(مسألة ٤٢): يستحب لمن رأى امرأة فأعجبته أن يجامع زوجته. نعم يكره أن يجامع الرجل امرأته بشهوة غيره. والظاهر أن المراد به ما إذا كان الداعي للجماع هو شهوة امرأة أجنبية خاصة اشباعاً لتلك الشهوة، بل ينتظر حينئذٍ حتى تهدأ فورة الشهوة بما يشغله عنه. أما الاول فالمراد به أن يكون الجماع لاشباع الشهوة حذراً من تعلق النفس بالاجنبية من دون أن تكون قد تعلقت بها فعل.
(مسألة ٤٣): يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلاً حتى يعلمهم.
(مسألة ٤٤): يجوز لكل من الزوجين التلذذ الجنسي بما يشاء من جسد الآخر، صغيراً كان أو كبيراً بجميع وجوه التلذذ من النظر واللمس والتقبيل وغيره، كما يجوز له الانزال بذلك. نعم يكره للرجل وطء الزوجة في دبره. بل يحرم إذا لم يكن برضاه.
(مسألة ٤٥): لا يجوز الدخول بالزوجة قبل أن يتم لها تسع سنين قمرية. لكن لو دخل بها لم تحرم عليه مؤبداً حتى لو أفضاه. كما أنه يجوز له الاستمتاع بها بغير الوطء.
(مسألة ٤٦): يجوز العزل عند الوطء بإخراج الذكر من الفرج وإراقة المني خارجه. نعم يكره العزل عن الحرة إذا لم يشترط ذلك عليها ولم ترض به، خصوصاً إذا كانت ممن يتوقع حملها وكانت ترضع ولدها ولم تكن سليطة
ولا بذيئة. والسليطة هي طويلة اللسان الصخابة. والبذيئة هي ذات الكلام الفاحش السافل.
(مسألة ٤٧): الامتناع عن الانجاب إن كان بتعقيم أحد الطرفين، بأن يتعطل جهازه التناسلي فلا ينجب أبداً فالأحوط وجوباً الاقتصار فيه على لزوم الضرر البدني من الاستمرار في الانجاب. وإن كان بتوقفه عن الانجاب مؤقتاً جاز اختيار، إلا أن يستلزم كشف العورة المحرم - كما لو توقف على الاستعانة بالطبيب أو الطبيبة - فيقتصر فيه على مورد الحاجة العرفية، بحيث يلزم من الانجاب الحرج أو الضرر.
(مسألة ٤٨): لا يجوز للمرأة الامتناع عن الحمل بما ينافي حق الزوج في الاستمتاع - كالعزل وعدم التمكين من الوطء في الوقت الذي يتوقع فيه قابلية البويضة للاخصاب - إلا برضا الزوج أو باشتراط ذلك عليه في عقد النكاح أو غيره من العقود اللازمة. وأما بالطرق الاُخرى غير المنافية للاستمتاع فالأحوط وجوباً استئذان الزوج في ذلك، إلا أن يكون الحمل مضراً بها فلا يجب استئذان الزوج حينئذٍ.
(مسألة ٤٩): المراد بالامتناع عن الانجاب في المسألة السابقة هو فعل ما يمنع من انعقاد النطفة وتلقيح البويضة به. أما بعد انعقاد النطفة وتلقيح البويضة بها فلا يجوز الاجهاض مهما قصرت المدة، ولا يسوغه تشوه الجنين ولا مرض المرأة أو إجهادها ولا الضائقة الاقتصادية، قال تعالى: (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم).
نعم يجوز مع الاطمئنان بتعرض الاُم للموت بدونه، بحيث يدور الامر بين موتها مع الجنين وموت الجنين وحده. ولابد من التثبت في ذلك.
(مسألة ٥٠): في مورد حرمة الاجهاض تجب الدية به، ويتحملها المباشر
الذي يستند الاجهاض لفعله، كالمرأة إذا شربت الدواء أو تحركت حركة عنيفة فأجهضت، وكالطبيبة إذا قامت بعملية الاجهاض. ولا يتحملها الذي يأذن به أو يطلب من الغير إيقاعه، كما لا تتحملها المرأة إذا سلمت نفسها للطبيبة فقامت بعملية الاجهاض، وإن كان ذلك كله محرم.
(مسألة ٥١): يجب على الزوجة تمكين الزوج من الوطء وغيره من الاستمتاعات في أي وقت شاء، وعلى أي حال كانت. ويحرم عليها الامتناع من ذلك مغاضبة أو للانشغال عنه، أو لخوف الحمل أو لغير ذلك. بل يستحب لها التزين والتطيب والتهيؤ له، بل عرض نفسها عليه. نعم إذا خافت على نفسها الضرر جاز لها الامتناع مما تخاف منه.
الفصل الثاني
في عقد النكاح
يحل النكاح بأحد وجهين..
الأول: الزواج.
الثاني: ملك اليمين.
وحيث يندر الابتلاء بالثاني في زمانن، فالمناسب الاقتصار على الاول.
وهو عقد يتضمن علقة خاصة معروفة بين الرجل والمرأة،بل مطلق الذكر والاُنثى وإن كانا صغيرين. وهو على قسمين..
الأول: الدائم.
الثاني: المنقطع.. والكلام هنا في الاول.
(مسألة ٥٢): لابد في هذا العقد من إنشائه باللفظ، فلا يقع بدونه، وإن
دلّ على إنشاء المضمون والالتزام به، كالتوقيع على ورقة العقد. وبذلك يخالف سائر العقود. نعم مع تعذر العقد - لخرس ونحوه - تجزئ الإشارة المفهمة له.
(مسألة ٥٣): لا يشترط في عقد النكاح العربية، فيجوز إيقاعة بكل لغة، وإن كان الأحوط استحباباً الإتيان به بالعربية مع الامكان.
(مسألة ٥٤): العقد عبارة عن الايجاب من أحد الطرفين والقبول من الآخر بأي وجه وقع، وذلك يكون..
تارة: بالايجاب من المرأة والقبول من الرجل بأن تقول: زوجتك نفسي بمهر كذ، فيقول: نعم أو رضيت أو قبلت.
واُخرى: بالايجاب من الرجل والقبول من المرأة بأن يقول: تزوجتك بمهر كذا فتقول: نعم، أو نحو ذلك.
(مسألة ٥٥): لا يتعين في الايجاب لفظ التزويج، بل يقع بلفظ النكاح وغيره مما يؤدي معنى الزواج، كما لو قالت المرأة: أنكحتك نفسي، أو قال الرجل: أنكحك، أو نحو ذلك.
(مسألة ٥٦): لا يشترط في عقد النكاح موافقة القواعد الاعرابية، بل يقع مع اللحن إذا قصد بالكلام إنشاء عقد الزواج به وكان مؤدياً لذلك عرف.
(مسألة ٥٧): لا يشترط الايجاب بلفظ الماضي، فكما يقع بمثل: تزوجت فلانة وزوجت فلاناً فلانة أو من فلانة وأنكحت فلاناً فلانة، يقع بمثل: أتزوج فلانة، واُزوج فلاناً فلانة أو من فلانة، وأنكح فلاناً فلانة.
(مسألة ٥٨): يصح إيقاع عقد النكاح من الطرفين مباشرة، فيقول الرجل: تزوجتك، أو تقول المرأة: زوجتك نفسي، ويقبل الطرف الآخر بنفسه، كما يصح إيقاعه ممن يقوم مقامهما كالولي والوكيل، فيقول ولي أحد الطرفين أو
وكيله مثلاً: زوجت فلاناً من فلانة، فيقبل الطرف الآخر بنفسه أو يقبل وليه أو وكيله عنه.
(مسألة ٥٩): يصح قيام شخص واحد مقام كلا الطرفين في العقد بأن يكون أصيلاً عن نفسه وولياً أو وكيلاً عن الطرف الآخر، أو ولياً أو وكيلاً عن كلا الطرفين، أو ولياً على أحدهما ووكيلاً عن الآخر. نعم لا يجوز أن توكل المرأة رجلاً في تزويجها من نفسه على أن يتولى طرفي العقد.
(مسألة ٦٠): مع قيام شخص واحد مقام كلا الطرفين في العقد لا يجب أن يوجب عن أحدهما ويقبل عن الآخر، بل يكفي إنشاؤه للمضمون عن كل منهما من دون حاجة للقبول.
(مسألة ٦١): يكفي في صورة عقد الزواج أن تقول المرأة للرجل الذي تريد الزواج به: زوجتك نفسي بمهر قدره كذ، أو تقول لوكيله: زوجت نفسي من فلان بمهر قدره كذ. أو يقول وكيلها للزوج: زوجتك فلانة بمهر قدره كذ، أو يقول لوكيله: زوجت فلانة من فلان بمهر قدره كذ، فيقول الزوج أو وكيله: قبلت. وإنما أثبتنا ذلك لانه المعروف وليسهل تعلمه على من يريده، وإلا فالصور المجزئة كثيرة، كما يظهر مما سبق.
(مسألة ٦٢): الزواج في المحاكم إن اقتصر فيه على تسجيل الزواج وتوقيع كلا الطرفين على ورقة العقد لم يصح ولم يترتب عليه الاثر، وإن اشتمل على الصيغة بالوجه المتقدم صح. وحبذا لو لم يقتصر القائمون بتسجيل الزواج على سماع إقرار كلا الطرفين برضاه بالزواج وأخذ توقيعه به، بل يلتزمون مع ذلك بإجراء الصيغة بين الطرفين بأخذ الوكالة عليها من أحدهما وإجرائها مع الآخر أو الطلب من الطرفين بإجرائها بينهما قبل التسجيل فإن في ذلك الحفاظ على الحكم الشرعي من دون كلفة.
الفصل الثالث
في أولياء العقد
(مسألة ٦٣): للاب والجد للاب - وإن علا - الولاية في النكاح على الولد والبنت الصغيرين، وكذا على المجنونين الكبيرين اللذين يتصل جنونهما بصغرهم. فإن زوجاهما نفذ التزويج عليهما وليس لهما الرجوع عنه إذا بلغا وتم رشدهم. وأيهما سبق صح تزويجه، فإن تقارنا أو تشاحا كان المقدم هو الجد.
(مسألة ٦٤): المراد بالجد للاب هو أبو الاب وأبو أبيه وإن عل، دون أبي اُم الاب أو أبي جدته أو نحوهما ممن يتصل بالاب من طريق النساء.
(مسألة ٦٥): يكفي في جواز تزويج الاب والجد للصغير عدم المفسدة، ولا يشترط ثبوت المصلحة. نعم لابد من عدم التفريط حينئذٍ، كما لو دار الامر بين زوجين لا مفسدة في التزويج منهما إلا أن أحدهما أصلح من الآخر، فإنه لا يجوز اختيار المرجوح، نظير ما تقدم في البيع.
(مسألة ٦٦): ليس لغير الاب والجد للاب من الارحام الولاية على الصغيرين كالاخ والجد للاُم والاعمام والاخوال وغيرهم.
(مسألة ٦٧): ليس للاب والجد ولا غيرهما الولاية في التزويج على البالغ الرشيد، رجلاً كان أو امرأة، بل يستقل بالولاية على تزويج نفسه، إلا في البنت البكر مع أبيها أو جدها فإن الولاية في التزويج تشترك بينها وبينهم، فلاينفذ نكاحها إلا بإذنها وإذن أحدهم، وإذا كانا معاً موجودين كفى إذن أحدهم. نعم لو تشاحا فالظاهر تقديم الجد.
(مسألة ٦٨): المراد بالبكر غير المتزوجة زواجاً يستتبع الدخول في القبل، سواءً لم تتزوج وبقيت بكارتها أو ذهبت من دون دخول أو بوطء محرم ولو عن شبهة، أم تزوجت ولم تذهب بكارتها أو ذهبت بغير وطء الزوج.
(مسألة ٦٩): ليست البنت بضاعة بيد الاب والجد يملكان التصرف فيها تبعاً لرغبتهم، بل اللازم عليهما ملاحظة مصلحتها وحاجتها الطبيعية للزواج وإن خرجا بذلك عن مقتضى العرف والعادة. بل تسقط ولايتهما على البنت مع منعهما لها من التزويج بنحو يضر بها عرف. كما تسقط ولايتهما بتعذر استئذانهما لمرض أو غيبة طويلة أو نحوهم، وحينئذٍ تستقل بنفسها بالتزويج ولا تحتاج إلى إذن أحد حتى الحاكم الشرعي.
(مسألة ٧٠): ليس لاحد من الارحام مع فقد الاب والجد للاب الولاية على البالغة البكر فضلاً عن غيره، بل تستقل فيه بنفسه. وما قامت عليه بعض الاعراف من تدخل الارحام ومنعهم للمرأة عما تريد، بل عما يريده لها وليها مع وجوده ظلم صارخ وخروج عن الموازين الشرعية وانتهاك لحدود الله تعالى وتجاهل لاحكامه في عباده. وهو من أسباب الفساد المهمة التي قد يترتب عليها ردود فعل لا تحمد عقباه، يتحمل المفسد عارها وشنارها في الدني، وتبعتها ومسؤوليتها في الآخرة، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون.
(مسألة ٧١): يكفي في إذن البكر سكوتها عند عرض التزويج عليها وعدم إبائها له، إلا مع وجود ما يثير احتمال كون السكوت عن غير رضاً منها بما عرض عليه، بحيث يكون أمرها مريباً أو يكون هناك أمارة على عدم الرضا منه. ولا فرق في ذلك بين وجود الاب أو الجد وعدمه. والمراد بالبكر هنا من بقيت بكارته، فلايعم من ذهبت بكارتها ولو بغير الوطء على الأحوط وجوب.
(مسألة ٧٢): إذا أوصى الاب أو الجد بالطفل أو المجنون لشخص،
فإن نص على أن له تزويجه كان له ذلك على النحو الذي يثبت للموصي، وإن لم ينص على ذلك فالأحوط وجوباً للوصي الاقتصار على صورة حاجة الموصى به للتزويج بمرتبة معتد بها ولو من غير جهة الرغبة الجنسية، كما لو احتاج للتزويج من أجل إدارة شؤونه الخارجية. لكن لابد من استئذان الوصي من الحاكم الشرعي، ومع تعذره فالأحوط وجوباً له استئذان عدول المؤمنين إن لم يكن الوصي منهم، ومع تعذره يستقل هو بالتزويج. لكن الأحوط وجوباً في صورة تعذر الرجوع للحاكم الاقتصار على صورة لزوم الضرر أو الحرج من الانتظار. وتقدم في كتاب الوصية ما ينفع في المقام.
(مسألة ٧٣): مع فقد الاب والجد والوصي لا يجوز تزويج الصغير ولا المجنون إلا مع الحاجة بالنحو المتقدم في المسألة السابقة، ويتولى ذلك من له تولي اُمورهما ممن تقدم التعرض له في مبحث الاولياء من فصل شروط المتعاقدين من كتاب البيع، والأحوط وجوباً مراجعة الحاكم الشرعي مع الامكان حتى لو كان المتولي لاُموره غيره، ومع تعذره يراجع العادل إن لم يكن المتولي لاُموره عادل.
(مسألة ٧٤): السفيه في الماليات إذا كان رشيداً في بقية الاُمور لا يستقل هو ولا وليه في تزويجه، بل لابد من اشتراكهما فيه ووقوعه بإذنهما مع.
(مسألة ٧٥): إذا وقع عقد النكاح من غير من له السلطنة عليه كان فضولياً وتوقف نفوذه على إجازة من له السلطنة، على نحو ما تقدم في البيع، وتقدم من فروعه ما يجري في المقام.
(مسألة ٧٦): كما يمكن وقوع عقد النكاح ممن له السلطنة عليه يمكن وقوعه من وكيله، على نحو ما تقدم في العقود.
الفصل الرابع
في أسباب التحريم
وهي اُمور..
الأول: النسب.
(مسألة ٧٧): يحرم نكاح الاُم وإن علت، كاُم أحد الابوين أو أحد الجدين وما فوق. والبنت وإن نزلت، كبنت البنت وبنت الولد وبنات أولادهما فما دون. والاُخت وبناتها وإن نزلن. والعمة والخالة وإن علتا كعمة الابوين والجدين وخالتهما وهكذ. وبنات الاخ وإن نزلن.
الثاني: المصاهرة وما اُلحق به.
(مسألة ٧٨): من تزوج امرأة حرمت مؤبداً على آبائه مهما علو، وعلى أبنائه مهما نزلو، سواءً دخل بها أم ل.
(مسألة ٧٩): من تزوج امرأة حرمت عليه مؤبداً اُمها وإن علت، سواء دخل بها أم لم يدخل. كما تحرم عليه بنتها وإن نزلت ما دامت الاُم في حبالته، ولا تحرم عليه البنت مؤبداً إذا لم يدخل بالاُم، فإن طلق الاُم أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له زواج البنت. أما إذا دخل بالاُم فإن ابنتها تحرم عليه مؤبد، من دون فرق بين ابنتها التي ولدتها قبل الزواج منه وابنتها التي ولدتها بعد الزواج منه.
(مسألة ٨٠): بنت الزوجة المدخول بها وإن كانت تحرم على الزوج مؤبداً إلا أنها لا تحرم على أبيه ولا على ابنه من زوجة اُخرى، فيجوز لهما الزواج منها وإن بقيت الاُم في حبالته.
(مسألة ٨١): تحرم اُخت الزوجة جمع، لا مؤبد، فلا يجوز له الزواج منها ما دامت اُختها في حبالته وإن كانت في عدتها الرجعية. أما إذا خرجت من حبالته - وإن كانت في عدة منه بائنة - فإنه يجوز له الزواج باُخته. إلا في عدة الزواج المنقطع، فإن الأحوط وجوباً عدم الزواج بأختها إلا بعد الخروج من عدة أخته.
(مسألة ٨٢): يجوز الزواج من المرأة على عمتها وخالتها بإذنهم، ولا يجوز بغير إذنهم. نعم إذا عقد بغير إذنهما ثم أجازتا صح العقد. وإن كان الأحوط استحباباً تجديد العقد بإذنهم.
(مسألة ٨٣): الظاهر أن الزنى لا ينشر التحريم، فمن زنى بامرأة لم تحرم عليه اُمها ولا بنته، ولا تحرم هي على أبيه ولا على ابنه. نعم الأحوط استحباباً أن لا يتزوج الزاني بعد الزنى اُم المزني بها ولا بنته، ولا يتزوج المزني بها أبو الزاني ولا ابنه، بل لو كان الزنى بعد الزواج قبل الدخول فالأحوط استحباباً ترتيب أثر الحرمة عليه، ومع منافاته لحقها يطلقه. أما إذا كان الزنى بعد الزواج والدخول فلا إشكال في عدم اقتضائه تحريم الزوجة.
(مسألة ٨٤): يستثنى من المسألة السابقة من زنى بعمته أو خالته، فإن الأحوط وجوباً له أن لا يتزوج ابنته. أما إذا كان الزنى بعد الزواج بالبنت فإنه لا يحرمه، خصوصاً إذا كان بعد الدخول به، كما تقدم في المسألة السابقة.
(مسألة ٨٥): الظاهر عدم إلحاق وطء الشبهة بالزنى في الاحتياط الوجوبي في المسألة السابقة. نعم يلحق به في الاحتياط الاستحبابي فيها وفي المسألة التي قبله. أما التقبيل واللمس والنظر بشهوة ونحوها فلا يلحق بالزنى حتى في الاحتياط الاستحبابي.
(مسألة ٨٦): اللواط من الرجل موجب لحرمة اُم الموطوء واُخته وبنته عليه فلا يجوز له أن يتزوج إحداهن، بل إن كانت إحداهن زوجة له قبل اللواط فالأحوط وجوباً له إذا تحقق اللواط ترتيب أثر الحرمة عليه، ومع منافاته لحقّها يطلقه. وإذا كان الواطئ صبياً فلا حرمة.
(مسألة ٨٧): الأحوط استحباباً أن لا يتزوج ابن الواطئ أو الموطوء بنت الآخر.
(مسألة ٨٨): يحرم التزويج دواماً وانقطاعاً من المزوجة دواماً وانقطاع، وكذا من المعتدة من دون فرق بين أقسام العدة. ولو وقع الزواج كان باطل.
(مسألة ٨٩): من تزوج امرأة مزوجة حرمت عليه مؤبد، إلا أن يكون جاهلاً ولم يدخل بها لا قبلاً ولا دبر، فإنها لا تحرم عليه مؤبد، بل له أن يجدد العقد عليها بعد أن تخرج عن حبالة زوجها وعن عدته.
(مسألة ٩٠): المدار في عدم الحرمة المؤبدة على جهل الزوج دون الزوجة، فلا تحرم عليه إذا كان جاهلاً وإن كانت عالمة. والمتيقن منه الجهل بالموضوع ، وهو أن لها زوج ، أما الجهل بالحكم - وهو حرمة تزويج ذات الزوج - ففي كفايته في المنع من الحرمة المؤبدة إشكال.
(مسألة ٩١): من تزوج امرأة في عدتها حرمت عليه مؤبد، إلا مع الجهل وعدم الدخول، نظير ما تقدم في المسألة السابقة. لكن لو كان أحدهما جاهلاً والآخر عامداً مع عدم الدخول تثبت الحرمة المؤبدة في حق العامد، وفي ثبوتها في حق الجاهل إشكال. كما أنه لا فرق هنا في الجهل المانع من الحرمة المؤبدة بين الجهل بالموضوع وهو كونها في العدة، والجهل بالحكم وهو حرمة التزويج في العدة.
(مسألة ٩٢): إذا تزوج المرأة في العدة جاهلاً ولم يدخل بها حتى خرجت من العدة ثم علم لم تحرم عليه مؤبد، بل له تجديد العقد عليه. وكذا لو تزوج ذات الزوج جاهلاً ولم يدخل بها حتى خرجت عن زوجية زوجها الاول وعن عدته. أما إذا دخل بها في عدته فالأحوط وجوباً حرمتها عليه مؤبد، خصوصاً إذا كانت العدة رجعية.
(مسألة ٩٣): لا يصح العقد على المتوفى عنها زوجها قبل أن يبلغها
الخبر. ولو حصل العقد حينئذٍ ففي جريان حكم تزوج المرأة في العدة - وهو الحرمة المؤبدة - إشكال، والأحوط وجوباً العمل على ذلك.
(مسألة ٩٤): يجوز تزوّج الزانية وإن كانت معروفة بالزنى. نعم يكره تزوجها لمن لم يعرف توبته، ولو بأن يدعوها للحرام فتأباه.
(مسألة ٩٥): يستحب لمن يريد أن يتزوج الزانية أن يستبرئها بحيضة خصوصاً إذا كان هو الزاني به، بل هو الأحوط - حينئذٍ - استحباب. وأما إذا كانت حاملاً فلا حاجة للاستبراء.
(مسألة ٩٦): من زنى بامرأة مزوجة - دواماً أو متعة - فالأحوط وجوباً ترتيب أثر حرمتها مؤبد، من دون فرق بين العلم بأنها مزوجة والجهل بذلك. وكذا إذا كانت معتدة عدة رجعية، دون غيرها من أقسام العدة.
(مسألة ٩٧): إذا زنت المرأة المزوجة لم تحرم على زوجه، نعم يستحب له استبراؤها بحيضة.
(مسألة ٩٨): إذا تزوج المُحرم بطل نكاحه، فإن كان عالماً بحرمة التزويج عليه حرمت عليه مؤبد، سواءً دخل بها أم لم يدخل، وإن كان جاهلاً لم تحرم عليه مؤبد، سواءً دخل بها أم لم يدخل. والأحوط وجوباً جريان ذلك في المحرمة.
(مسألة ٩٩): يحرم الجمع بين أكثر من أربع نساء بالزواج الدائم. ويجوز ما زاد على ذلك في الزواج المنقطع.
الثالث من أسباب التحريم: الرضاع.
ويشترط في الرضاع المحرم اُمور..
الأول: أن يكون بالامتصاص من الثدي، ولا يكفي التغذي بحليب المرأة بطريق آخر.
الثاني: أن تكون الرضعة تامة، بحيث يمتلئ الرضيع ويشبع، ولا يكفي في
التحريم الرضعة القليلة، لقلة لبن المرأة، أو لعدم تقبل الرضيع للرضاع مهما كثر العدد. نعم لا يضر الفصل القليل غير المعتد به الذي يكثر حصوله في الرضعة الواحدة لانشغال الطفل بلعب قليل أو لتبديل الثدي أو نحوهم. ولا فرق في اعتبار الشرط المذكور بين الرضاع العددي وغيره من الوجوه الثلاثة الاتية.
الثالث: أن يكون خمس عشرة رضعة، أو يوماً وليلة، أو يشد العظم وينبت اللحم والدم بحيث يزيد نمو الطفل المرتضع به عرف.
(مسألة ١٠٠): لابد في التحريم في الخمس عشرة رضعة وباليوم والليلة من التوالي بين الرضعات، بمعنى عدم الفصل بين الرضعات برضاع امرأة غيره. وكذا بغير الرضاع من طرق التغذية في اليوم والليلة. بل هو الأحوط وجوباً في الخمس عشرة رضعة. وأما فيما يشد العظم وينبت اللحم والدم فلا يخل الفصل برضاع آخر فضلاً عن غيره من طرق التغذية، إلا إذا كان الفاصل كثيراً بحيث لا يستند الانبات والاشتداد للرضاع عرف.
(مسألة ١٠١): لابد في نشر الحرمة بالرضاع يوماً وليلة من إرضاع الطفل كلما احتاج للرضاع في المدة المذكورة، ولا يكفي حبسه على الرضاع من امرأة خاصة من دون أن يكتفي به.
الرابع: أن يكون الرضاع من مرضعة واحدة بلبن فحل واحد، فلا حرمة لو رضع الطفل تمام المقدار المذكور من امرأتين أو أكثر وإن كان لبنهن لفحل واحد، فلا يكون ولداً للفحل المذكور. كما لا حرمة لو رضع تمام المقدار المذكور من امرأة واحدة ملفقاً من لبن فحلين - لو أمكن ذلك - فلا يكون ابناً للمرضعة المذكورة.
الخامس: أن يكون اللبن عن ولادة، فلو درّ لبن المرأة من دونها فأرضعت ولداً لم ينشر الرضاع المذكور الحرمة. والأحوط وجوباً أن لا تكون الولادة من زنى.
السادس: أن يكون قبل بلوغ الطفل الرضيع سنتين. والأحوط وجوباً أن
يكون قبل فطامه أيض، وقبل مضي سنتين من ولادة صاحبة اللبن.
(مسألة ١٠٢): إذا تحقق الرضاع بشروطه المتقدمة صار الرضيع ابناً للمرضعة ولصاحب اللبن، فيترتب على ذلك ما يترتب على بنوته لهما نسب، فيصير أولادهما له إخوة وأخوات وآباؤهما له أجداداً وجدات وإخوتهما له أعماماً وأخوالاً وأخواتهما عمّات وخالات، وهكذ. ويترتب حينئذٍ أثر العلاقة الحاصلة من حيثية التحريم بها أو بالمصاهرة المترتبة عليها أو بالجمع المترتب عليها أو نحوه. فكما يحرم على الرجل نكاح بنته الرضاعية يحرم عليه نكاح زوجة ابنه الرضاعي، ويحرم الجمع بين الاُختين الرضاعيتين، ويحرم نكاح المرأة على عمتها الرضاعية أو خالتها إلا بإذنه، وهكذ.
(مسألة ١٠٣): كما تتحقق بالرضاع العلاقة المحرمة بين المرتضع ومن يتعلق بصاحب اللبن أو بالمرضعة بالنسب تتحقق بينه وبين من يتعلق بهما بالرضاع، فكما يحرم المرتضع على آبائهما وأبنائهما وإخوانهما النسبيين يحرم على آبائهما وأبنائهما وإخوانهما الرضاعيين. ويستثنى من ذلك ما إذا أرضعت امرأة واحدة أطفالاً من لبن فحولة مختلفين، فإن كلاً منهم وإن صار ابناً لها فيحرم عليها وعلى آبائها وإخوتها النسبيين والرضاعيين، إلا أنه لا تحصل الاُخوّة المحرِّمة بين المرتضعين أنفسهم لاختلاف الفحل، بل يجوز النكاح بينهم. كما لا يحصل ما يترتب عليها من العلاقات المحرِّمة، فكما لا يكون أحدهم أخاً للآخر من الرضاعة لا يكون عماً أو خالاً لابنه أو بنته. نعم تتحقق الاُخوّة المحرِّمة بين ولدها الرضاعي وأولادها النسبيين حتى من كان منهم ولداً لغير صاحب اللبن.
(مسألة ١٠٤): مما تقدم يظهر أن من وسائل تحليل نظر الرجل للمرأة الاجنبية أن يتزوج طفلة رضيعة فترضعها تلك المرأة بالشروط المتقدمة، فإنها تصير اُم زوجته.
(مسألة ١٠٥): يحرم على أبي المرتضع - وإن علا - أن يتزوج أولاد صاحب اللبن وأولاد أولادهم - مهما نزلوا - نسبيين كانوا أو رضاعيين، كما يحرم عليه أن يتزوج أولاد المرضعة النسبيين، دون أولادها الرضاعيين إذا رضعوا من لبن فحل آخر غير الفحل الذي ارتضع ابنه من لبنه. وعلى ذلك ينبغي الحذر من إرضاع الطفل من قبل جدته لاُمه أو زوجة جده لاُمه، لان ذلك يوجب حرمة اُمه على أبيه وبطلان نكاحهم، لأن النسبة الرضاعية كما تمنع من صحة النكاح لو كانت سابقة عليه توجب بطلانه لو حصلت بعده. أما إرضاعه من قبل جدته لابيه فلا يوجب تحريم اُمه على أبيه، غايته أنه يصير أخاً لابيه ولاعمامه وعماته فيحرم على أولاد أعمامه لانه يصير عماً لهم بالرضاع وعلى أولاد عماته لانه يصير خالاً لهم بالرضاع.
(مسألة ١٠٦): لا يحرم أولاد صاحب اللبن على إخوة المرتضع الذين لم يرتضعوا معه.
(مسألة ١٠٧): يثبت الرضاع المحرِّم بالعلم وبالبينة، ولا يثبت بدعوى المرأة الارضاع، ولا بشهادة النساء وإن كنّ أربع، إلا أن يحصل العلم من قولها أو من قولهن.
الرابع من أسباب التحريم: اللعان، بشروطه المقررة التي يأتي الكلام فيها في آخر كتاب الطلاق.
(مسألة ١٠٨): يلحق باللعان قذف الزوج زوجته الخرساء وكل من لا تستطيع الكلام فإن ذلك يوجب حرمتها وإن لم تلاعن. والمتيقن من ذلك ما إذا تمت بقية شروط اللعان، وأما بدونها فلا يخلو التحريم عن إشكال.
الخامس: الطلاق تسع، على ما يأتي في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى.
السادس: الكفر، على التفصيل الاتي.
(مسألة ١٠٩): لا يجوز نكاح المسلمة من الكافر مطلق، كتابياً كان أو غيره.
(مسألة ١١٠): لا يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة غير الكتابية مطلقاً دواماً ومتعة.
(مسألة ١١١): يجوز للمسلم أن يتزوج اليهودية والنصرانية دواماً ومتعة على كراهة، خصوصاً في الدوام ومع وجود المسلمة عنده أو تيسر الزواج به.
(مسألة ١١٢): يشترط في نكاح اليهودية والنصرانية على المسلمة دواماً إذن المسلمة في ذلك، ويكفي رضاها بالتزويج بعد وقوعه. ولا يشترط اذنها في التزويج بهما متعة.
(مسألة ١١٣): يجوز نكاح المجوسية متعة على كراهة أشد من نكاح اليهودية والنصرانية. أما نكاحها دواماً فلا يخلو عن إشكال، والأحوط وجوباً الترك.
(مسألة ١١٤): الارتداد عن الاسلام قسمان..
الأول: الفطري، وهو ارتداد من ولد على الاسلام إما من أب مسلم أو من أبوين مسلمين. وأما ولادته من اُم مسلمة وأب كافر فيشكل حاله، ولا سيما وأن ذلك لا يتم بناء على ما سبق من حرمة تزويج المسلمة من الكافر، إلا في وطء الشبهة أو في فروض نادرة. هذا والظاهر أنه لا يشترط في المرتد الفطري أن يصف الاسلام بعد البلوغ، بل يكفي أن يولد على الاسلام بالمعنى المتقدم.
الثاني: الملي، وهو ارتداد من ولد على الكفر ثم أسلم.
إذا عرفت هذا فإذا ارتد الزوج ارتداداً فطرياً بانت منه زوجته، ووجب عليها أن تعتد منه عدة الوفاة، سواءً كان قد دخل بها أم لم يدخل. أما إذا كان ارتداده ملياً ففي بينونة زوجته منه إشكال، خصوصاً إذا كان قد دخل به. نعم لا إشكال في أنها تعزل عنه ويمنع من الاستمتاع به. كما لا إشكال في بينونته
منه بعد خروج العدة. وعدتها عدة الطلاق. نعم إن مات في أثناء العدة المذكورة فالأحوط وجوباً أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجه.
(مسألة ١١٥): إذا ارتدت الزوجة عن الاسلام، فإن صارت غير كتابية بانت من زوجها المسلم وبطل نكاحهم. وإن صارت كتابية فالظاهر عدم بينونته، بل تبقى في حبالته، سواءً دخل بها أم لم يدخل، وسواءً كان ارتدادها فطرياً أم ملي.
(مسألة ١١٦): الارتداد وإن كان مبطلاً للنكاح - على التفصيل السابق - إلا أنه لا يمنع من النكاح المستجد بعده، لا في الرجل ولا في المرأة، بل إن بقي المرتد على ارتداده لحقه حكم دينه الذي اختاره، وإن رجع إلى الاسلام لحقه حكم المسلم، فله نكاح المسلمة حتى زوجته الاولى بتجديد العقد عليه، من دون فرق بين الارتداد الفطري والملّي.
(مسألة ١١٧): الارتداد الفطري حده القتل إلا أنه بنفسه بمنزلة الموت موجب لميراث مال المرتد وصيرورته لورثته حين الارتداد. نعم لا مانع من تملكه مالاً جديداً بعد ارتداده فيستقر له ولا يورث إلا بقتله أو بموته، أما الارتداد الملي فهو لا يوجب القتل إلا بعد أن يستتاب المرتد ثلاثة أيام ولا يورث ماله بارتداده بل بموته أو قتله.
(مسألة ١١٨): إذا ارتدت المرأة لم تقتل بل تستتاب وتحبس ويضيق عليها ولا يورث مالها بالارتداد من دون فرق بين الارتداد الفطري والملي.
(مسألة ١١٩): لابد في ترتب الاثر على الارتداد من أن يكون المرتد بالغاً عاقلاً مختاراً قاصد.
(مسألة ١٢٠): إذا أسلم الزوجان الكافران معاً بقيا على نكاحهم.
(مسألة ١٢١): إذا كان الزوجان كافرين فأسلم أحدهما دون الآخر
قبل الدخول بطل نكاحهم. وإن أسلم بعد الدخول لزم التربص فإن أسلم الآخر في مدة عدة الطلاق بقيا على نكاحهم، وإن لم يسلم حتى خرجت العدة بطل نكاحهم. ويستثنى من ذلك ما إذا أسلم الزوج وكانت الزوجة يهودية أو نصرانية، فإنها تبقى في عصمته ولا يبطل زواجهم، سواءً أسلم قبل الدخول أم بعده، وسواءً أسلمت بعده في العدة أم بقيت على الكفر.
(مسألة ١٢٢): الافضل للمؤمن أن يتزوج المؤمنة، ولا بأس أن يتزوج المستضعفة، ويكره له تزويج المخالفة غير المستضعفة. كما يكره تزويج المؤمنة من المستضعف، وأشد منه تزويجها من المخالف غير المستضعف. والأحوط وجوباً عدم نكاح الناصبي والناصبية.
(مسألة ١٢٣): إذا خيف الضلال من نكاح المخالف أو المخالفة حرم ولم يبطل.
الفصل الخامس
في زواج المتعة
وهو الزواج إلى وقت محدد، بحيث ينتهي به من دون حاجة للطلاق. وقد ثبت تشريعه بإجماع المسلمين، وأجمع أهل البيت (عليهم السلام) وشيعتهم أعز الله دعوتهم على عدم نسخه، وتشهد بذلك الاخبار الكثيرة التي رووها هم وجمهور المسلمين.
(مسألة ١٢٤): لابد في زواج المتعة من الايجاب والقبول اللفظيين، على نحو ما تقدم في الزواج الدائم. ويكفي فيه أن تقول المرأة للرجل: زوجتك نفسي إلى وقت كذا بمهر قدره كذ، فيقول الزوج: قبلت. أو يقول الرجل:
أتزوجك إلى وقت كذا بمهر قدره كذ، فتقول المرأة: قبلت. ويجزئ غير ذلك من الصور كما يظهر مما تقدم في الزواج الدائم.
(مسألة ١٢٥): يشترط في زواج المتعة ذكر المهر، فإن لم يذكر بطل، وبذلك يختلف عن الزواج الدائم.
(مسألة ١٢٦): يشترط في زواج المتعة ذكر الأجل، فإن نسيا ذكره أو استحييا منه أو اكتفيا بالقصد إليه من دون تصريح به في العقد صار الزواج دائم.
(مسألة ١٢٧): الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء عن الأجل بتعيين عدد المواقعة كالمرة والمرتين. ولو حصل ذلك فالأحوط وجوباً الطلاق ثم تجديد العقد. نعم لا بأس باشتراط العدد زائداً على الوقت، فيجعل الأجل يوماً مثلاً ويشترط العدد الخاص فيه.
(مسألة ١٢٨): لابد من ضبط الأجل وتعيينه، ولا يكفي الأجل المردد بين الاقل والأكثر كقدوم المسافر، فلو وقع ذلك بطل ولم يقع متعة ولا دائم.
(مسألة ١٢٩): لابد من تعيين الوقت، ولا يكفي تحديده من دون تعيين، كما لو تزوجها شهراً ولم يعينه، فإنه يبطل حينئذٍ ولا يقع متعة ولا دائم. بل الأحوط وجوباً أن يكون متصلاً بالعقد، فلو اشترط شهراً معيناً منفصلاً عن العقد جدد العقد، ولا يقع دائم.
(مسألة ١٣٠): ليس في المتعة طلاق، بل تبين بانقضاء الأجل وبهبة المدة.
(مسألة ١٣١): إذا عينا أجلاً ثم أرادا الزيادة عليه فالأحوط وجوباً تجديد العقد بعد انتهاء الأجل أو هبة المدة، ولا يكفي اتفاقهما على الزيادة بالاجر في أواخر الأجل قبل خروجه.
(مسألة ١٣٢): يجوز لولي الصغيرين تزويجهما متعة بمدة قليلة لا يكونان
فيها قابلين للاستمتاع، بل لغرض آخر كالتحريم المترتب على المصاهرة. نعم لابد من عدم لزوم المفسدة أو التفريط في حق الصغيرين، كما تقدم في أولياء العقد.
(مسألة ١٣٣): يجوز لولي الصغير أن يهب المدة في زواج المتعة إذا كان ذلك صلاحاً له.
الفصل السادس
في العيوب والشروط
النكاح عقد لازم، بل يمتاز عن كثير من العقود اللازمة بعدم إمكان فسخه بالتقايل، ولا بالاشتراط ولا بتخلف الشرط. نعم يثبت الخيار فيه في بعض الموارد الخاصة - على ما يتضح في المسائل الاتية - ولا يتعدى عنه.
(مسألة ١٣٤): للزوجة الخيار في فسخ النكاح بجنون الزوج قبل العقد أو بعده ولو بعد الوطء.
(مسألة ١٣٥): للزوجة الخيار في فسخ النكاح إذا عجز الزوج عن الوطء لعنن أو عمل شيطاني أو لكونه ممسوحاً أو مجبوباً أو نحو ذلك. وإن وطأها مرة واحدة فلا خيار. وكذا إذا كان قادراً على وطء غيرها من النساء، فإنه لا خيار لها ما دام قادراً على غيره، فإذا تجدد له العجز عن غيرها أيضاً ثبت الخيار له.
(مسألة ١٣٦): ليس للزوجة المبادرة للفسخ مع عجز الزوج عن الوطء، بل ترافعه للحاكم فيؤجله سنة، فإن قدر على وطئها أو وطء غيرها فلا خيار، وإلا كان لها الخيار.
(مسألة ١٣٧): للزوجة الخيار في فسخ النكاح إذا كان الزوج خصياً حين العقد عليه.
(مسألة ١٣٨): إذا تزوجت المرأة الرجل على أنه من قبيلة خاصة فبان من غيرها كان لها الخيار في فسخ العقد، سواء ظهر ذلك قبل الوطء أم بعده.
(مسألة ١٣٩): للزوج خيار فسخ النكاح بأحد اُمور في زوجته..
الأول: الجنون.
الثاني: الجذام.
الثالث: البرص.
الرابع: كل عيب فيها مانع من وطئها أو موجب لصعوبته، كرتق موضع الوطء أو غدة فيه أو عليه أو لحمة أو عظم، بل حتى ضيق المسلك بنحو غير متعارف بحيث يعد عيب.
الخامس: الافضاء، وهو اتصال مخرج الحيض والغائط وانخرام الحاجز بينهم.
السادس: العمى، وهو فقد البصر، ولو مع فتح العينين.
السابع: العرج.
الثامن: الزن.
وإنما توجب هذه الاُمور الخيار إذا كانت قبل العقد، دون ما إذا كانت بعده قبل الوطء أو بعده.
(مسألة ١٤٠): لا فرق في ثبوت الخيار في عيوب الزوج والزوجة بين الزواج الدائم والمنقطع.
(مسألة ١٤١): ليس الخيار المذكور في عيوب الرجل والمرأة فوري، بل لصاحب الخيار التراخي في ذلك ولا يسقط خياره إلا بإسقاطه أو بالرضا بالعقد بعد العلم بالعيب. نعم يكفي في الرضا من الزوج الوطء بعد العلم بالعيب. بل الأحوط وجوباً ذلك في الزوجة، فيكون تمكينها للزوج من الوطء
بعد العلم بالعيب مسقطاً للخيار.
(مسألة ١٤٢): الفسخ حلّ لعقد النكاح فيسقط به المهر ويسترجعه الزوج مع عدم الدخول إلا في العنن، فإن عليه معه نصف المهر، وكذا في الخصاء على الأحوط وجوب. وأما مع الدخول فإنها تستحق بسببه تمام المهر الذي جعله له. لكن مع التدليس والغش يكون له الرجوع بالمهر على من دلسه، وإن كانت هي المدلِّسة استرجعه منه. أما مع عدم التدليس منها ولا من غيرها فلا يرجع به.
(مسألة ١٤٣): إذا تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيباً فليس له الخيار في فسخ العقد، نعم ينتقص من المهر بنسبة التفاوت بين مهر البكر والثيب، والأحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا ثبت أن ارتفاع بكارتها بسبب وطء سابق، دون ما إذا كان بسبب آخر أو احتمل ذلك. ولا ينتقص المهر في غير ذلك من العيوب.
(مسألة ١٤٤): لا يثبت الخيار بسبب المرض المُعدي أو نحوه في أحد الزوجين، سواءً كان قبل العقد أم بعده، نعم إذا خاف الآخر من الضرر جاز له اعتزال المريض بالمقدار الذي يندفع به احتمال الضرر، فإن كان المعتزِل حينئذٍ هو الزوجة لم تسقط نفقته، وإن كان هو الزوج لم يجب عليه الطلاق الرافع لحقوق الزوجية، إلا أن يلزم الضرر على الزوجة من الاعتزال، فالأحوط وجوباً حينئذٍ للزوج الطلاق إذا لم يؤد لها حقوقه.
ثم إن ما سبق يختص بما إذا لم يعلم أحد الزوجين بمرض الآخر حين العقد ولم يقدم على ذلك، أما إذا علم به وأقدم عليه فاللازم عليه القيام بحقوق الزوجية للآخر وإن لزم الضرر، إلا أن يكون الضرر شديداً يحرم إيقاعه بالنفس فيجب تجنبه بالاعتزال.
(مسألة ١٤٥): إذا تزوج المريض امرأة توقفت صحة زواجه على دخوله به، فإن دخل بها صح زواجه وترتبت عليه جميع الاثار، وإن لم يدخل بها بطل
زواجه ولم يترتب عليه الاثر، فلا ميراث بينهما ولا مهر ولا عدة.
والمعيار في المرض ما يظهر ويصدق به أنه مريض عرف، دون الامراض الكامنة التي لا مظهر لها ولا يدركها إلا الاطباء بطرقهم الخاصة.
(مسألة ١٤٦): إذا كانت المرأة مريضة صح الزواج منها ولو مع عدم الدخول.
(مسألة ١٤٧): تخلف الشرط في عقد النكاح وإن لم يوجب الخيار في فسخه كما تقدم، إلا أنه يجب الوفاء بالشرط الواجد للضوابط المتقدمة في مبحث الشروط من كتاب البيع. ولا يجب الوفاء به بدونها من دون أن يوجب ذلك بطلان العقد.
(مسألة ١٤٨): إذا اشترطت الزوجة في العقد أن لا يطأها أو أن لا يخرجها من بلدها أو من بيتها وجب على الزوج الوفاء بذلك إلا أن تتنازل عن شرطه.
(مسألة ١٤٩): إذا اشترطت الزوجة على الزوج في العقد أن لا يتزوج عليها وجب الوفاء بالشرط، بل لو تزوج بطل زواجه إلا أن ترضى به ولو بعد ذلك.
(مسألة ١٥٠): إذا اشترطت الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو في عقد آخر أن يطلقها في حال خاص - من مرض أو سفر أو غيرهما - نفذ الشرط ووجب الوفاء به، وكذا لو اشترطت عليه أن لا يطلقها فإنه لا يصح منه الطلاق حينئذٍ.
(مسألة ١٥١): إذا اشترطت عليه أن يوكلها على طلاق نفسها في أي وقت شاءت، أو في حال خاص - كمرض أو سفر طويل أو سجن أو غير ذلك - وجب عليه أن يوكله. وإذا اشترطت عليه مع ذلك أن لا يعزلها لم يصح منه عزله، بل يصح ضم التوكيل لعقد النكاح مشروطاً بعدم العزل، كما لو قالت: زوجتك نفسي وجعلت نفسي وكيلة عنك في طلاقي منك على أن لا تعزلني، فقال: قبلت. فإنها تصير زوجة له ووكيلة عنه بلا حاجة للتوكيل ثاني، وحينئذٍ
يصح طلاقها لنفسه. نعم لا يجوز أن تشترط عليه أن بيدها الطلاق، بحيث يكون وقوع الطلاق وعدمه منوطاً بها لا به، بل يبطل الشرط المذكور.
الفصل السابع
في المهر
وهو كل شيء له مالية ويحل التكسب به، وإن قلّ، عيناً كان أو ديناً أو منفعة، كخياطة الثوب وتعليم القرآن. وأما ما لا يحل التكسب به، كالخمر والخنزير وآلات اللهو والمنافع المحرمة، فلا يصح جعله مهر.
(مسألة ١٥٢): لابد من جعل المهر ملكاً للزوجة في العقد، فإن جعل لغيرها من أب أو أخ أو غيرهما بطل النكاح، وكذا لو اشترط الولي شيئاً له من مهره. نعم لها أن تشترط هي شيئاً لغيرها غير المهر زائداً عليه.
(مسألة ١٥٣): لا يصح نكاح الشغار، وهو: أن يتزوج شخصان امرأتين على أن يكون مهر كل منهما زواج الاُخرى، مثل أن يزوج الرجل اُخته من رجل على أن يزوجه ذلك الرجل اُخته. وهو من أنكحة الجاهلية. وأما إذا اشتمل الزواج على المهر واشترط فيه زواج آخر، فالزواج صحيح والشرط باطل إلا أن يرضى به الزوجان الآخران.
(مسألة ١٥٤): لابد في الزواج من المهر، وإن ابتنى على عدم المهر بطل، أما لو أهملا ذكره في العقد من دون أن يبتني على عدمه فإن كان العقد منقطعاً بطل أيضاً كما تقدم، وإن كان دائماً صح، لكنها تستحق مهر المثل بالدخول، فإن طلقها قبل الدخول كان عليه المتعة، وذلك بأن يعطيها شيئاً على حسب حاله من حيثية الغنى والفقر. والاولى مع ذلك مراعاة حالها أيضاً فلا يدفع لها ما لا
يناسب شأنه. والأحوط وجوباً ثبوت المتعة أيضاً بموت أحدهما قبل الدخول، فلابد من التصالح.
(مسألة ١٥٥): إذا كان طلاق غير المدخول بها التي لم يسمَّ لها مهر خلعياً فلا متعة له، وفي المباراة إشكال.
(مسألة ١٥٦): من تزوج امرأة على حكم أحدهم، فإن كان العقد منقطعاً بطل، وإن كان دائماً صح، وحينئذٍ إن كان الحكم للزوج ثبت للزوجة ما يحكم به الزوج قلّ أو كثر، وإن كان الحكم للزوجة لم يكن لها أن تتجاوز مهر السنة. فإن مات أحدهما قبل الحكم وقبل الدخول فلا حكم حينئذٍ، بل تستحق المتعة إن كان الميت هو الحاكم، بل مطلقاً على الأحوط وجوب. وإن كان بعد الدخول، فإن كان الميت هو الحاكم استحقت مهر المثل، وإن كان الميت هو الآخر كان للحاكم أن يحكم على التفصيل المتقدم، فينفذ حكمه، وكذا ينفذ حكمه لو كان الموت بعد الحكم مطلق.
(مسألة ١٥٧): تملك المرأة المهر بالعقد، وإطلاقه يقتضي التعجيل فلها حينئذٍ المطالبة به كامل، بل لها الامتناع من تسليم نفسها حتى تقبضه، سواءً كان الزوج موسراً أم معسر. لكن لو دخل الزوج بها قبل التسليم لم يكن لها الامتناع بعد ذلك من أجل أن تستلمه، فلو امتنعت حينئذٍ كانت ناشز. نعم يجب على الزوج حينئذٍ تسليمه مع مطالبتها به وقدرته عليه، كسائر الديون.
(مسألة ١٥٨): يجوز اشتراط التأجيل في المهر، فإن ابتنى التأجيل على تأجيل تسليم نفسها تبعاً للمهر كان لها الامتناع من تسليم نفسها قبل الأجل وبعده حتى تستلم المهر، ولا تكون فائدة التأجيل حينئذٍ إلا عدم استحقاقها المطالبة بالمهر قبل الأجل. وإن لم يبتن على ذلك - بأن يكون الغرض من المهر المؤجل التوثق لبقاء الزواج أو لمجرد تكريم المرأة بتكثير مهرها كما يتعارف في
عصورنا - فليس للمرأة الامتناع من تسليم نفسها من أجل قبض المهر، سواء طلب الزوج إدخالها عليه قبل الأجل أم لم يطلبه حتى حلّ الأجل.
(مسألة ١٥٩): مع إطلاق التأجيل في المهر - بتمامه أو في بعضه - من دون ذكر أجل لا تستحق تسليم المهر إلا بالطلاق أو الموت، ويجوز للزوج التعجيل بأدائه. ومع تعيين الأجل يتعين العمل عليه، إلا أن يراد استحقاق التأجيل ما دامت عنده، كما هو غير بعيد في زمانن، وحينئذٍ يجب تسليمه بالطلاق وإن حصل قبل الأجل، كما يحل بالموت مطلق.
(مسألة ١٦٠): يكفي تعيين الأجل في الجملة، مثل ورود المسافر ووضع الحمل، ولو كان مبهماً بحتاً سقط الأجل وكان معجل.
(مسألة ١٦١): يسقط نصف المهر في الزواج الدائم بالطلاق قبل الدخول، وبموت أحد الزوجين قبله. ويستقر تمامه بالدخول ولو دبر، ولا يقوم مقامه إزالة البكارة بغير الوطء. نعم يثبت مع إزالة بكارتها بغير إذنها مهر المثل، فإن دخل بها بعد ذلك أو قبله ثبت تمام المهر المسمى أيض. وكذا يثبت مهر المثل على غير الزوج لو أزال بكارة المرأة بغير إذنه.
(مسألة ١٦٢): في الزواج المنقطع لا يسقط شيء من المهر بانقضاء الأجل أو الموت قبل الدخول، وفي سقوط نصفه بهبة المدة قبل الدخول إشكال. نعم إذا أخلت بتمكين نفسها من الوطء بعض المدة مع طلبه منها أو شرطه عليها سقط من المهر بالنسبة، سواءً كان الاخلال لعذر أم ل. ويستثنى من ذلك أيام الحيض أو النفاس أو الاحرام أو نحو ذلك مما يحرم فيه الوطء. هذا إذا كان الغرض المهم من الزواج هو الوطء، أما إذا كان الغرض بقية الاستمتاعات فالاخلال بها بعض المدة موجب لنقص المهر وإن صادف أيام الحيض مثل. والمدار في تبعيض المهر على تبعيض مدة الحضور، لا على التبعيض في وجوه الاستمتاع.
(مسألة ١٦٣): إذا دفع الزوج للزوجة شيئاً عوضاً عن مهرها ثم طلقها قبل الدخول أو مات أحدهما رجع نصف المهر المسمى، لا نصف ما دفعه له.
(مسألة ١٦٤): إذا أبرأت الزوجة الزوج من مهرها أو من بعضه ثم طلقها قبل الدخول أو مات أحدهما كان عليها نصف المهر. وكذا إذا قبضت المهر ثم تلف عندها وطلقها قبل الدخول أو مات أحدهم.
(مسألة ١٦٥): إذا كان المهر عيناً فقبضتها ثم زادت عندها أو نقصت وطلقها أو مات أحدهما قبل الدخول رجع نصف قيمتها بلحاظ حالها حين قبضه. أما إذا زادت القيمة السوقية أو نقصت من دون تغيير في العين فاللازم دفع نصف العين وإن اختلفت القيمة.
(مسألة ١٦٦): إطلاق عقد النكاح يقتضي ثبوت المهر في ذمة الزوج. ويمكن أن يتحمله عنه غيره بأن يشترط ذلك في العقد. بل إذا زوج الاب ولده الصغير ولم يكن للولد مال كان المهر على الاب وإن لم يشترط ذلك في العقد.
(مسألة ١٦٧): إذا تحمل غير الزوج المهر فطلق الزوج أو مات أحد الزوجين قبل الدخول لم يرجع نصف المهر للزوج، بل لمن تحمله. وكذا إذا كان المهر على الزوج فتبرع به غيره عنه.
(مسألة ١٦٨): من وطأ امرأة شبهةً بعقد فاسد قد اشتمل على المهر كان عليه ذلك المهر، فإن لم يشتمل العقد على المهر كان عليه مهر المثل، وكذا عليه مهر المثل إذا وطأها شبهة بغير عقد. نعم إذا كان مغروراً كان له الرجوع على من غره. وإن كانت هي التي خدعته سقط مهره.
(مسألة ١٦٩): لا يثبت للمرأة شيء من المهر بالعقد الفاسد من دون وطء. نعم في عقد الفضولي من دون وطء يحتمل ثبوت نصف المهر المسمى على الفضولي لا على الزوج، واللازم الاحتياط.
(مسألة ١٧٠): لا يثبت شيء مع الزنى من دون شبهة. والمعيار في الزنى والشبهة على الزوجة لا على الزوج.
(مسألة ١٧١): من وطأ امرأة مكرهاً لها كان عليه مهر المثل له.
(مسألة ١٧٢): الهدايا التي تتعارف في عصورنا لكل من الزوجين بمناسبة الزواج لا يلحقها حكم المهر، بل يلحقها حكم الهبة، فتلزم إذا كان المهدي رحماً أو عوضت الهدية أو تصرف المهدى له فيها تصرفاً مغيراً لصورته، على ما تقدم توضيحه في كتاب الهبة. ولا تتنصف بالطلاق قبل الدخول. نعم لا يبعد ابتناء هبة النيشان وبعض الملابس التقليدية على عدم الطلاق قبل الدخول، بحيث يكون مشروطاً بذلك ارتكاز، فإن تمّ ذلك تعيّن ثبوت الخيار لدافع الاُمور المذكورة بحصول الطلاق قبل الدخول حتى مع حصول أحد الملزمات.
(مسألة ١٧٣): يكره زيادة المهر، حتى ورد عنهم (عليهم السلام) أن من بركة المرأة قلة مهرها ومن شؤمها كثرة مهره. كما يكره الزيادة على مهر السنة، وهو خمسمائة درهم فضة، تكون ألفاً وأربعمائة وسبعة وثمانين غراماً ونصفاً من الفضة تقريب.
(مسألة ١٧٤): إذا وقع العقد الشرعي على مهر خاص، واُعلن مهر آخر أو ثبّت عند تسجيل الزواج في المحكمة كان الثابت هو المهر الذي وقع عليه العقد، ويحرم العمل على غيره.
(مسألة ١٧٥): يكره الدخول بالمرأة قبل دفع شيء لها من مهره، أو هدية خارجة عن المهر.
الفصل الثامن
في القسمة والنشوز
(مسألة ١٧٦): تستحق الزوجة الدائمة على الزوج المبيت عندها في كل ليلة من أربع ليال، سواءً كان عنده غيرها أم لم يكن. ولا تستحق ذلك المتمتع به.
(مسألة ١٧٧): المبيت الواجب هو المبيت المبني على الايناس وحسن المعاشرة بالوجه المتعارف، ولا يكفي ما يبتني منه على الهجر والاعراض والنفرة.
(مسألة ١٧٨): يجوز لمن كان عنده أكثر من امرأة أن يفضل بعض نسائه على بعض في المبيت والمواقعة والنفقة بما يزيد عما تستحقه منه من دون أن ينقص الاُخرى عن حقه. فمن كان عنده زوجتان جاز له أن يبيت عند إحداهما ثلاث ليال وعند الاُخرى ليلة واحدة. إلا أن يكنّ أربعاً فلا مجال للتفضيل في المبيت.
نعم يكره له تفضيل بعضهن، بل ينبغي له أن يجهد في العدل بينهن في جميع الاُمور عدا الميل النفسي الذي قد يخرج عن الاختيار. وقد حكي عن بعض الاكابر ممن كان له نساء أربع أنه كان يقول: إن إحداهن في نفسي كالعقرب ولا يستطعن أن يعرفن من هي.
(مسألة ١٧٩): إنما يجب المبيت مع الحضور في البلد، ويجوز السفر وترك المبيت عند الزوجة. إلا أن يخرج السفر عن المتعارف في كثرته ويبتني على إهمال حق المرأة عرفاً بنحو ينافي المعاشرة بالمعروف، فالأحوط وجوباً إرضاؤها حينئذٍ. كما أن الأحوط وجوباً مع تعدد النساء المحافظة على الدورة عند
الرجوع، فيبدأ بصاحبة النوبة عند حصول السفر.
(مسألة ١٨٠): إذا كان الزوج ممن لا يتسنى له المبيت في بيته لعمل يتعيش به أو نحوه ففي سقوط حق الزوجة في القسمة إشكال، فالأحوط وجوباً التصالح معه. ومع الاضطرار لذلك وإبائها فالأحوط وجوباً تعويضها بالصيرورة عندها في النهار.
(مسألة ١٨١): إذا كانت الزوجة أمة أو كتابية كان لها ليلة من ثمان.
(مسألة ١٨٢): من تزوج امرأة جاز له تفضيلها عند إدخالها عليه بأن يبقى عندها ثلاث ليال، بل إن كانت بكراً جاز له أن يزيدها إلى سبع ليال.
(مسألة ١٨٣): للمرأة أن تتنازل عن ليلتها رغبة عنه، وزهداً فيها - لملل أو نحوه - أو تجنباً لمحذور - كالطلاق - أو تعرضاً لامر ترغب فيه كزيادة النفقة أو الاذن في الخروج أو نحو ذلك. ولها العدول عن ذلك بعد صدوره منه، إلا أن يلزمها بشرط أو عقد لازمين.
(مسألة ١٨٤): إن تنازلت الزوجة عن ليلتها لزوجها كان له أن يقضيها حيث شاء، وإن تنازلت عنها لضراتها أجمع دخلت في قسمتهن، فإذا كنّ ثلاثاً مثلاً كان لكل منهن ليلة من ثلاث، وإن تنازلت عنها لواحدة بعينها اختصت به، فتكون لها ليلتان. لكن التنازل في الاخيرين لا ينفذ على الزوج إلا أن يرضى به، ولو رضي به كان له العدول إلا أن يلزمه بشرط أو عقد لازمين.
(مسألة ١٨٥): تستحق الزوجة على الزوج الوطء في القبل في كل أربعة أشهر، من دون فرق بين الشابة وغيره. والظاهر عدم كفاية مسمى الوطء، بل ما يتعارف الإتيان به لاشباع الحاجة الجنسية. وفي عموم ذلك للمتمتع بها إشكال، وإن كان أحوط وجوب. كما تستحق عليه أيضاً النفقة، على ما يأتي في الفصل العاشر إن شاء الله تعالى.
(مسألة ١٨٦): إذا ترك الزوج وطء زوجته أربعة أشهر مغاضباً لها رفعت أمرها للحاكم الشرعي فيلزمه بأحد أمرين: الوطء أو الطلاق، نظير ما يأتي في الايلاء. أما لو ترك وطأها من دون مغاضبة بل لعجز أو سفر أو نحوهما ففي رجوعها للحاكم الشرعي إشكال والاظهر العدم.
(مسألة ١٨٧): يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاعات - عدا الوطء في الدبر - وإزالة المنفر، بل التهيؤ والتطيب والتزين بما يهيؤه الزوج لها ويطلبه منه.
(مسألة ١٨٨): يحرم على الزوجة الخروج من منزل زوجيتها إلا بإذن زوجها أو بإحراز رضاه، إلا أن تضطر لذلك للتداوي أو نحوه مما تتضرر بتركه أو يتوقف عليه أداء واجب كحجة الاسلام. أما لو أخرجها عن منزل زوجيتها فذهبت إلى منزل آخر فالظاهر جواز خروجها حينئذٍ منه بغير إذنه.
(مسألة ١٨٩): للزوجة أن تعمل ما شاءت من غير إذن الزوج في بيتها من الاعمال التي تتكسب بها وغيرها ما لم يناف حق الزوج في الاستمتاع أو يوجب التعدي على ملكه.
(مسألة ١٩٠): إذا نشزت الزوجة فلم تؤد للزوج حقه كان له وعظه، فإن لم ينفع هَجَرها في المضجع بأن يوليها ظهره ويعرض عنه، فإن لم ينفع ضربها من دون إدماء لحم ولا كسر عظم.
(مسألة ١٩١): إذا نشز الزوج لم يكن للزوجة النشوز معه والامتناع عن أداء حقه، نعم لها أحد أمرين..
الأول: أن ترفع أمره للحاكم الشرعي، فيلزمه بأداء الحق، ومع امتناعه له تعزيره.
الثاني: أن تتنازل عن بعض حقوقها كالمبيت ونحوه، تأليفاً له وتجنباً لتفاقم الامر حذراً من الطلاق.
(مسألة ١٩٢): إذا وقع الشقاق بين الزوجين والتنافر بينهما فالاولى عدم التسرع في الطلاق وعدم إهمال الامر حتى يتفاقم الشر، بل يختار كل منهما حكماً عنه، وإن أمكن أن يكون من أهله فعل، ولينظر الحكمان في مشكلتهما وليجهدا في تقريب وجهات النظر والاصلاح، مع صدق النية منهما في ذلك، فإن تعذر ذلك لم يكن لهما اختيار البذل والطلاق إلا مع تحقق شروط الخلع أو المباراة ورضا الزوجين به أو عموم وكالتهما له، ومع اتفاق الحكمين عليه.
(مسألة ١٩٣): حيث جعل الله سبحانه القيمومة للزوج فالمنتظر منه القيام بما يناسب ذلك من مقتضيات الحكمة، وذلك بسعة الصدر ومحاولة تخفيف الازمة واستيعاب المشاكل والتروي في حلها والصبر على الاذى، والتسامح عن الخطأ وغفران الزلل وتجنب الغضب والضجر واللجاجة والحرص ونحوها من وسائل الشيطان الرجيم مستعيناً بالله تعالى ومستمداً منه التوفيق والتسديد.
كما ينبغي للمرأة أن تعرف موقعها وتتحمل مسؤوليتها ولا تنسى أن جهادها الذي أراده الله تعالى منها حسن التبعل ومحاولة إرضاء الزوج والتجاوب معه، فإنه أعظم حقاً عليها من كل أحد، حتى ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «لو أمرت أحداً أن يسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجه». وما جعل الله سبحانه كلاًّ من الزوجين في موقعه وأدبه بأدبه إلا حفاظاً على كيان العائلة ومحاولة لاسعاد أفرادها وراحتهم، فعليهما شكر ذلك وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم، والحذر من نزغات الشيطان الرجيم وتسويلات النفس الامارة بالسوء، وتجنب الاندفاع في سورة الغضب والانفعال، حيث قد يصلان بذلك إلى ما لا تحمد عقباه ولا يمكن تلافيه، والله سبحانه من وراء القصد.
الفصل التاسع
في أحكام الاولاد
يلحق الولد بصاحب النطفة التي انعقد منه، سواء كان الانعقاد عن طريق الوطء أم بدونه، كما لو سال مني الرجل فدخل فرج المرأة، أو اُدخل بآلة، أو لقحت بويضتها بحيمن الرجل خارج الرحم ثم اُدخلت البويضة في الرحم، أو غير ذلك.
(مسألة ١٩٤): توصل العلم الحديث إلى تلقيح بويضة المرأة بحيمن الرجل خارج الرحم ثم زرعها في رحم امرأة اُخرى فتحضنها حتى يستكمل الجنين نموه فتلده. وفي إلحاق الولد حينئذٍ بصاحبة البويضة أو بالحاضنة التي حملته وجهان أقربهما الاول. وكذا يلحق بصاحبة البويضة لو فرض استكمال نموه خارج الرحم في حاضنة صناعية. وإن كان الظاهر أن ذلك فرض مجرد لا واقع له الان.
(مسألة ١٩٥): يجوز تلقيح بويضة المرأة بنطفة زوجه، من دون فرق بين تلقيحها في الرحم - بطريق الوطء أو بإدخال المني من دون وطء - وتلقيحها خارج الرحم. وأما تلقيحها بنطفة أجنبي فهو حرام إذا كان التلقيح في الرحم بطريق الوطء المحرم أو بمجرد إدخال المني، بل الأحوط وجوباً تركه مطلقاً وإن كان التلقيح خارج الرحم، إذا استتبع دخول البويضة بعد التلقيح في الرحم. بل مطلق، إلا أن لا يستتبع التلقيح تكوّن آدمي، بل كان لمحض التجارب العلمية في مرحلة بدائية.
(مسألة ١٩٦): الأحوط وجوباً عدم حضن المرأة بويضة ملقحة بنطفة
غير زوجه، سواء كانت البويضة لها أم لغيره، ويجوز حضنها لبويضة ملقحة بنطفة زوجه، سواء كانت البويضة لها أم لغيره، كما لو كان للرجل زوجتان فاستخرجت بويضة إحداهما ولقحت بحيمنه ثم اُودعت رحم الاُخرى.
(مسألة ١٩٧): لما كان استخراج البويضة وإرجاعها للرحم مستلزماً لكشف العورة للاجنبي ومسها غالباً فهو محرم من هذه الجهة، ولا يحل إلا بمبرر يبلغ حد الحرج أوالضرر. وكذا الحال لو توقف التلقيح على الاستمناء من الرجل.
(مسألة ١٩٨): قد سبق المعيار في إلحاق الولد بالرجل والمرأة وحينئذٍ تترتب مع المعيار المذكور جميع آثار الاُبوة والاُمومة، كحرمة النكاح وجواز النظر والنفقة والميراث وغير ذلك. ويستثنى من ذلك التوارث، فلا يترتب مع الانتساب بسبب الزنى وهو وطء المرأة من دون زواج ولا ملك يمين ولا اشتباه بأحدهم.
(مسألة ١٩٩): إذا كان الوطء عن شبهة من أحد الطرفين دون الآخر تمّ التوارث بين الولد والطرف الذي حصل الاشتباه له، دون الطرف الآخر الذي لا شبهة منه، بل كان وطؤه زناءً.
(مسألة ٢٠٠): إذا حملت المرأة من الزنى لم ينفع زواجها من الواطئ في ارتفاع حكم الزنى فلا يترتب التوارث بين الزاني والولد.
(مسألة ٢٠١): قد سبق حرمة تلقيح بويضة المرأة بنطفة الرجل الاجنبي عمداً؟ وحينئذٍ هل يترتب معه حكم الزنى في عدم التوارث بين الطفل والمتعمد للتلقيح المحرم؟ إشكال. فاللازم الاحتياط.
(مسألة ٢٠٢): هل تلحق النفقة بالتوارث في الاستثناء المتقدم مع الزنى؟ إشكال. فاللازم الاحتياط أيض.
(مسألة ٢٠٣): إذا علم بأن الولد قد انعقد من حيمن الرجل
فلا إشكال، وإن لم يعلم فإذا حملت الزوجة الدائمة أو المنقطعة اُلحق الحمل بالزوج بشروط..
الأول: وطؤه لها وطءً يحتمل كونه سبباً للحمل، أو ما يقوم مقامه، كإراقته المني على فرجها بنحو يحتمل دخوله في رحمها وتلقيحها به.
الثاني: ولادة الحمل تاماً - بحيث تستقر فيه الحياة - بعد ستة أشهر من الوطء المذكور أو ما اُلحق به، فلو ولد لاقل من ستة أشهر وعاش فهو ليس له.
الثالث: عدم تجاوز أقصى الحمل، وهو سنة قمرية على الاظهر. فمع تحقق الشروط المذكورة يحرم على الاب نفي الولد.
(مسألة ٢٠٤): إذا اعترف الزوج بتحقق الاُمور المذكورة لم يقبل منه نفي الولد. أما إذا لم يعترف بها فله نفي الولد إذا كانت المرأة التي حملت بالولد زوجة متمتعاً بها أو أمة، وكذا إذا كانت زوجة دائمة لم يثبت دخوله به. أما إذا ثبت دخوله بها فلا يقبل منه نفي الولد إلا باللعان، أو بإقامة البينة على ما يمنع من تولد الولد منه، كاعتزالها أو غيبة طويلة عنها أو نحو ذلك.
(مسألة ٢٠٥): إذا ادعى عدم الدخول فالقول قوله بيمينه إلا أن تقيم الزوجة البينة على أنه اختلى بها خلوة يمكن معها الدخول عادة.
(مسألة ٢٠٦): إنما يلحق الولد بالزوجين - مع الشروط المتقدمة - إذا تصادقا على أن الزوجة قد حملت به، أو ثبت ذلك بالعلم أو البينة، ولا يلحق بدون ذلك، كما إذا ولدت الزوجة في المستشفى مثل، فدفع لها ولد واحتملت هي أو الزوج أن الذي ولدته طفل آخر.
(مسألة ٢٠٧): إذا طلقت المرأة ثم ولدت قبل مضي مدة أكثر الحمل من طلاقها اُلحق الولد بزوجها مع تحقق الشروط المتقدمة فيه. هذا إذا لم تتزوج أما إذا تزوجت قبل ولادتها فسيأتي الكلام فيه.
(مسألة ٢٠٨): إذا طلقت الزوجة الدائمة أو انقضى أجل المتمتع بها فاعتدت وتزوجت ثم ولدت ولداً تاماً لستة أشهر فما زاد من زواجها الثاني اُلحق الولد بزوجها الثاني مع تحقق الشروط المتقدمة فيه. وإن ولدت لاقل من ستة أشهر منه، أو لم تتحقق الشروط المتقدمة فيه لم يلحق الولد به، وحينئذٍ إن لم تمض مدة أكثر الحمل لخروجها عن زوجية الاول اُلحق الولد بزوجها الاول مع تحقق الشروط المتقدمة فيه، وانكشف أن الزواج الثاني في عدة الاول فتحرم على الثاني مؤبداً إن كان قد دخل به. وإن مضت مدة أكثر الحمل لخروجها عن زوجية الاول أولم تتم الشروط المتقدمة فيه لم يلحق الولد به أيض.
(مسألة ٢٠٩): إذا وطأ الرجل المرأة شبهةً اُلحق الولد به مع تحقق الشروط المتقدمة فيه، إلا أن تكون المرأة مزوجة أو في العدة الرجعية، فإنه إن علم بلحوق الولد بالواطئ أو بالزوج عُمل به، وإن تردد بينهما يقرع بينهما ويعمل على مقتضى القرعة.
(مسألة ٢١٠): المراد بوطء الشبهة هنا هو الوطء عن شبهة من جانب الرجل الواطىء، وإن كانت المرأة الموطوءة زانية لعلمها بالحال.
(مسألة ٢١١): إذا تردد الولد بين الزوج والزاني اُلحق بالزوج.
(مسألة ٢١٢): إذا تردد الولد بين اثنين اُقرع بينهما وعُمل على مقتضى القرعة، كما إذا ولدت زوجتان لزوجين واشتبه ولد كل منهما بولد الآخر، أو ولدت زوجتان لرجل واحد واشتبه ولد كل منهما بولد الاُخرى، أو وطء رجلان امرأة شبهة أو كان أحدهما زوجها وأمكن إلحاق الولد بكل منهما إلى غير ذلك. نعم إذا كان أحدهما زانياً والآخر صاحب فراش - ولو لكونه واطئاً بشبهة - كان الترجيح للثاني و الحق به الولد من دون حاجة للقرعة.
(مسألة ٢١٣): يقبل من الرجل الاقرار بالولد الذي يولد من امرأة هي
فراش له، وكذا من امرأة يتصادق معها على أنها فراش له، سواءً سبق منه نفيه عنه أم ل. نعم إذا سبق منه نفيه عنه اُلزم بنفيه في حق نفسه، لا في حق الولد، فيرثه الولد ويجب عليه نفقته ولا يرث هو الولد ولا يجب على الولد نفقته. هذا وإذا أقر بالولد في فرض كون اُمه فراشاً له فليس له بعد ذلك نفيه حتى باللعان. كما لا يسمع من الولد الانتفاء منه إلا بالبينة. هذا كله مع احتمال صدقه في الاقرار بالولد. أما مع العلم بكذبه به لخروجه عن الضوابط المتقدمة في لحوق الولد بأبيه فلا أثر للاقرار المذكور.
(مسألة ٢١٤): إذا أقر بولد امرأة لم يثبت كونها فراشاً له فلا يقبل الاقرار ولا تثبت بنوة الولد إلا مع كون الولد تحت يده وفي حوزته، إذا لم يكن هناك ما يوجب الريب في صدقه، ويكفي في الريب تكذيب الولد له إذا كان مميزاً يدرك معنى التكذيب. وكذا الحال في المرأة فإنه يقبل منها دعوى بنوة الولد الذي هو في حوزتها مع عدم ما يوجب الريب في صدقه. بل الظاهر جريان ذلك في جميع الارحام. نعم إذا كبر الطفل وأنكر النسب - مدعياً العلم أو قيام الحجة على نفيه - ففي إلزامه به إشكال، بل منع في جميع الفروض المتقدمة.
(مسألة ٢١٥): إذا تصادق شخصان كبيران على نسب بينهما - كالبنوة والاُخوة والعمومة والخؤولة وغيرها - واستمرا على ذلك ولم يرجعا عنه ولم يكن هناك من يكذبهما فيه - مدعياً العلم بذلك أو قيام الحجة عليه - ثبت النسب المدعى بينهما وترتب أثره من ميراث أحدهما من الآخر أو ممن يتقرب به وميراث الآخر ومن يتقرب به منه إلى غير ذلك من آثار االنسب. نعم في ثبوت لازم النسب المدعى إشكال، كما لو تصادقا على الاُخوة، حيث يشكل البناء على كون أحدهما ولداً لاب الآخر ليرث منه مع بقية أولاده أو ابن أخ لعمه، فلا يترك الاحتياط، خصوصاً إذا كان للمورث ورثة آخرون.
(مسألة ٢١٦): يثبت النسب بالبينة، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشاهد ويمين حتى بالاضافة إلى الميراث على الأحوط وجوب.
(مسألة ٢١٧): من ادعى نسباً لا تنهض دعواه بإثباته لاخلاله بالشروط المتقدمة يلزم بالحقوق المترتبة عليه بمقتضى النسب الذي يدعيه أخذاً له بإقراره إذا تمت شروط الاقرار.
(مسألة ٢١٨): يحرم على الرجل والمرأة تبني طفل لم يتولد منهما ولم يحكم عليه شرعاً بأنه لهم، ولا أثر للتبني المذكور شرعاً في وجوب النفقة أو حرمة النكاح أو الميراث أو غيرهما من أحكام البنوة. وقد ألغى الاسلام التبني المذكور الذي كان شايعاً في الجاهلية قال تعالى: (وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل * ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم)، كما يحرم على الانسان أن يتبرأ من نسبه وينتسب لغير أبيه، ففي الصحيح عن الامام الصادق (عليه السلام) قال: «كفر بالله من تبرأ من نسب وإن رق»، ومن المؤلم ما نراه اليوم من رجوع هذه العادة الجاهلية عند بعض الناس غافلين أو متغافلين عن حكم الاسلام القاطع في ذلك. فإنا لله وإنا إليه راجعون.
هذ، وأما التربية والكفالة للطفل الذي لا يعرف أهله أو يضعف أهله عن تربيته وكفالته من دون أن يدعيه المربي والكافل ويتبناه فهو إحسان محض يشكر فاعله. لكن يجب الحذر من أن يؤدي ذلك لاشتباه النسب أو ضياعه. وكذا الحال في تسجيل الطفل باسم غير أبيه في دائرة النفوس بحيث يكون ولداً له بحسب القوانين الوضعية. فإنه لا بأس به في نفسه، بل قد يحسن إذا توقف عليه حل مشكلة قانونية ما لم يؤد ذلك لاشتباه النسب أو ضياعه أو ترتب آثاره بوجه غير شرعي من ميراث ونحوه فإنه يحرم حينئذٍ كما ذكرن. والحذر ثم الحذر من مخالفة أحكام الله تعالى وتعدي حدوده وانتهاك حرماته
بعد أن أوضح الحق وأقام أعلامه ولم يبق عذراً لمعتذر إذ قد يكون ذلك سبباً للنكال والوبال في الدنيا والآخرة للمجتمع الذي يشيع فيه ذلك فضلاً عمن يباشره ويقوم به.
(مسألة ٢١٩): يحرم عند الولادة اطلاع الرجل على المرأة بنحو يقتضي النظر لما يحرم عليه النظر منه، خصوصاً العورة، إلا مع الاضطرار، فيقتصر على مقدار الضرورة.
(مسألة ٢٢٠): ينبغي للمؤمن إذا بشّر بمولود أن لا يسأل عن أنه ذكر أو اُنثى، بل يسأل عن استواء خلقته، فإذا كان سوياً قال: «الحمد لله الذي لم يخلق مني خلقاً مشوه» فإن علم بعد ذلك أنه ذكر شكر الله على نعمته، وإن كان اُنثى لم يكره اختيار الله تعالى له، وفي الحديث: «البنات حسنات والبنون نعمة والحسنات يثاب عليها والنعمة يسأل عنه».
(مسألة ٢٢١): يستحب عند الولادة اُمور..
الأول: غسل المولود. والظاهر احتياجه للنية من قبل الغاسل.
الثاني: أن تكون الخرقة التي يلف بها بيضاء، ويكره أن تكون صفراء.
الثالث: أن يؤذن في اُذنه اليمنى أذان الصلاة، ويقام في اليسرى. والاولى أن يكون قبل قطع سرته.
الرابع: أن يحنك بماء الفرات وبتربة الحسين (عليه السلام) فإن لم يتيسر فبماء السماء. وأن يحنك بالتمر، بل العسل أيض.
والمراد جعل هذه الاُمور في حنكه. وللانسان حنكان: أعلى الفم من داخل، وأسفله تحت اللسان في مقدم الفم، فيحتاط بجعله فيهما مع.
(مسألة ٢٢٢): من حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه، وقد ورد أن أصدق الاسماء ما تضمن العبودية لله تعالى - كعبد الله وعبد الرحيم - وأفضله
أسماء الانبياء، وأفضلها (محمد)، بل ورد: أن من ولد له أربعة أولاد، بل ثلاثة، ولم يسم أحدهم باسم محمد فقد جفا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، كما ورد أيضاً الحث على التسمية بعلي، وفي الحديث: «إن الشيطان إذا سمع منادياً ينادي: يا محمد أو يا علي ذاب كما يذوب الرصاص»، وورد عنهم (عليهم السلام): «لا يدخل الفقر بيتاً فيه اسم محمد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء». كما يكره التسمية بأسماء أعداء أهل البيت (عليهم السلام) ، وورد عنهم (عليهم السلام): «ان الشيطان إذا سمع منادياً ينادي باسم عدوّ من أعدائنا اهتز واختال» والمراد به الاسم الذي يعرف بمرور الزمن لاعدائهم، بحيث ينصرف لهم عند إطلاقه، فلا تكره التسمية به قبل ذلك.
(مسألة ٢٢٣): يستحب تسمية المولود عند ولادته بمحمد إلى اليوم السابع، ثم يترك بعد ذلك أو يغيّر.
(مسألة ٢٢٤): يستحب تكنية المولود بأن يضاف لاسمه اسم مبدوء بأب إن كان ذكراً أو مبدوء باُم إن كان اُنثى، فإن لم يكنَّ في صغره استحب له أن يكتني إذا كبر وإن لم يكن له ولد. ويكره التكنية بأبي عيسى وأبي الحكم وأبي مالك وأبي مرة، وكذا بأبي القاسم إن كان اسمه محمد.
(مسألة ٢٢٥): يستحب حلق شعر الصبي في اليوم السابع والتصدق بوزنه ذهباً أو فضة.
(مسألة ٢٢٦): يستحب ختان الصبي يوم السابع، ويكره تأخيره عنه. وإذا بلغ غيرُ المختون وجب عليه أن يختن نفسه. ولابد في الختان من قطع تمام الغلفة وهي اللحمة التي تغطي الحشفة، وإن نبتت الغلفة بعد الختان وجبت إعادته. ومن ولد مختوناً استحب إمرار الموسى على مقطع الغلفة منه.
(مسألة ٢٢٧): يستحب أن يقال عند ختان الصبي: «اللهم هذه سنتك
وسنة نبيك٨، واتباع منا لك ولدينك بمشيئتك وبإرادتك، لامر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته، فأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته لامر أنت أعرف به مني. اللهم فطهره من الذنوب وزد في عمره وادفع الافاتِ عن بدنه والاوجاع عن جسده وزده من الغنى وادفع عنه الفقر، فإنك تعلم ولا نعلم». وعن الصادق (عليه السلام): «من لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم، فإن قالها كفي حرّ الحديد من قتل أو غيره».
(مسألة ٢٢٨): يستحب مؤكداً العقيقة عن الصبي في اليوم السابع، فإن لم يعق عنه في اليوم السابع عقّ عنه بعد ذلك، بل لو كبر ولم يعلم بأنه عق عنه أو لا استحب له أن يعق عن نفسه. بل قد يظهر من بعض النصوص استحباب أن يعق الكبير عن نفسه وإن سبق أن عق عنه في صباه. كما يستحب قضاؤها لو مات بعد السابع، بخلاف ما لو مات قبله.
(مسألة ٢٢٩): لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنه، نعم تجزئ عنها الاُضحية.
(مسألة ٢٣٠): العقيقة شاة أو بقرة أو بدنة، ويستحب تعددها عن الواحد، ولا تجزئ الواحدة عن أكثر من واحد.
(مسألة ٢٣١): أفضل العقيقة كبش، خصوصاً عن الذكر، وأفضلها أسمنه، ولا يشترط فيها شروط الاُضحية.
(مسألة ٢٣٢): يستحب أن يقال عند ذبح العقيقة: «بسم الله وبالله عقيقة عن فلان لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه، اللهم اجعله وقاءً لال محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) » ووردت أدعية اُخرى يضيق المقام عن ذكره.
(مسألة ٢٣٣): يكره أن يأكل الابوان وعيالهما منه. وتتأكد الكراهة في الاُم، بل الأحوط استحباباً الترك. ويدفع للقابلة ثلثها أو ربعها أو رجل منها مع
الورك أو بدونه. فإن لم تكن قابلة اُعطيت حصتها للام تدفعه لمن تشاء، ويطبخ الباقي ويقسم على المؤمنين أو يدعى عليه نفر منهم، ويستحب أن يكونوا عشرة فإن زادوا فهو أفضل، فيأكلون ويدعون للصبي. ويجوز إهداؤها لحماً لم يطبخ. والأحوط وجوباً تخصيص ما عدا حصة القابلة بالمؤمنين، وعدم دفعها لغيرهم ممن لا يوالي أهل البيت (عليهم السلام) وعدم إطعامه منه.
(مسألة ٢٣٤): يستحب أن تقطّع العقيقة أعضاءً تامة، ويكره أن يكسر لها عظم. وأما ما اشتهر بين سواد الناس من لف العظام بخرقة ودفنها فلم نعثر له على سند شرعي.
(مسألة ٢٣٥): لا يشرع لطخ رأس الصبي بدم العقيقة، وهو من فعل الجاهلية، بل يلطخ بالخلوق، وهو - كما قيل - ضرب من الطيب أكثر أجزائه الزعفران.
(مسألة ٢٣٦): أفضل المراضع الاُم، وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن اُمه». لكن لا تجبر الاُم على إرضاع ولده، ولو أرضعته كان لها المطالبة بالاُجرة من ماله إن كان له مال، وإلا فمن مال أبيه إن كان له مال، وإلا فمن مال من تجب نفقته عليه الذي يأتي التعرض له في الفصل العاشر.
فإن رضيت بما يرضى به غيرها من تبرع أو اُجرة فهي أحق بإرضاعه، وإن طلبت ما زاد على ذلك لم يجب إجابته، سواءً زاد على اُجرة المثل أم ل. نعم يستحب ترك الطفل حينئذٍ مع اُمه وإرضاعه منه.
(مسألة ٢٣٧): أتم الرضاع شرعاً عامان، ويجوز الزيادة على ذلك. وأقل الرضاع شرعاً واحد وعشرون شهر. والظاهر جواز النقص عن ذلك - مع عدم ظهور حاجة الصبي له - على كراهة.
(مسألة ٢٣٨): الولي على الصبي هو الاب، إلا أن للاُم أن تطالب
بحضانته وذلك بتولي شؤون عيشه وتربيته، ويكون في حجرها حينئذٍ تحت نظر أبيه وفي رعايته، كما هو مقتضى ولايته عليه. والظاهر اختصاص ذلك بمدة الرضاع، فإذا فطم - ولو قبل مضي سن الرضاع الشرعي - سقط حقها في الحضانة، واختص بذلك أبوه.
(مسألة ٢٣٩): إذا طلقت الاُم تبقى حضانتها في مدة الرضاع ما لم تتزوج، فإذا تزوجت سقطت حضانته، وكان للاب أن يضعه حيث يشاء. وإذا طلقت لم تعد لها الحضانة.
(مسألة ٢٤٠): إذا ماتت الاُم في مدة الرضاع سقطت حضانتها ولا تنتقل لورثتها ولا لوصيه.
(مسألة ٢٤١): إذا طلبت الاُم أجراً زائداً على الرضاع فاسترضع الاب غيرها سقطت حضانته.
(مسألة ٢٤٢): إذا سقط الاب عن الولاية بموت أو جنون فالحضانة للاُم حتى لو كانت تزوجت، وليس لوصي الاب أو الجد للاب انتزاعه منه، فإذا عادت الولاية للاب عادت له الحضانة إذا كان الطفل قد فطم.
(مسألة ٢٤٣): حق الحضانة الذي يكون للاُم يسقط بإسقاطه، ولها إسقاطه دفعة، كما لها إسقاطه تدريج، مدة فمدة. أما ولاية الاب وحضانته للطفل فهي لا تقبل الاسقاط، ولو رضي بتركها مدة وإيكال أمر الصبي لغيره من أجل مصلحة الصبي كان له الرجوع عن ذلك متى شاء.
(مسألة ٢٤٤): الظاهر عدم استحقاق الاُم الاُجرة على الحضانة زائداً على اُجرة الرضاع، فلو طالبت بالاُجرة كان له انتزاع الصبي منها ودفعه لغيرها ولو باُجرة. نعم للاب أن يستأجرها حينئذٍ بما يتفقان عليه فتستحق الاجر.
(مسألة ٢٤٥): لو اعتدى الاب أو غيره على الاُم ومنعها من حضانة
الطفل مدة من الزمن، فلا يتدارك ذلك بالقضاء، ولا بدفع القيمة أو نحوه.
(مسألة ٢٤٦): إذا فقد الابوان فلا حق لاحد في حضانة الصبي، بل هي تابعة للولي فيضعه حيث يراه صلاحاً له.
(مسألة ٢٤٧): إذا بلغ الصبي رشيداً فلا ولاية للابوين ولا غيرهما عليه، ويكون الخيار له في الانضمام لمن يشاء منهما أو من غيرهما أو الاستقلال.
(مسألة ٢٤٨): يستحب تقبيل الصبي والتصابي له وملاعبته، وينبغي إشعاره بعطف الاُبوة وحنوه.
(مسألة ٢٤٩): يستحب تمرين الصبي على العبادات، كالصلاة والصيام والصدقة، والتدرج معه في ذلك حسب إدراكه وطاقته، على وجوه مذكورة في المطولات، ولا ينبغي إهمال ذلك والتهاون به، خصوصاً الصلاة فقد ورد أنه يلزم بها لسبع سنين.
(مسألة ٢٥٠): ينبغي للاب تربية ولده تربية يصلح بها في دينه وبدنه وخلقه، فقد ورد: أن من حقوق الولد على أبيه أن يحسن أدبه، وقد ورد أنه يترك للعب ست سنين أو سبع سنين ويلزمه الاب نفسه فيؤدبه بأدبه ويعلمه الكتاب سبع سنين ويعلمه الحلال والحرام سبع سنين. كما يلزم إبعاده - بالتفهيم والتعليم وبالحكمة والموعظة الحسنة - عن آداب الكفر والجاهلية وعن الانحلال والرذيلة. ولا ينبغي التهاون في ذلك والتفريط فيه، ففي ذلك فساده وفساد المجتمع وانحلاله، وقد قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار).
كما ينبغي على المؤدب الرفق معه واللين والاناة في ذلك وفي جميع الاُمور وحسن المعاشرة والمخالطة، و التحبب والتودد حتى ينجذب إليه ويتقبل منه ويتفاعل معه، قال تعالى: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة)، وعن
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «إن الرفق لم يوضع على شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه»،. وقال: «رحم الله والدين أعانا ولدهما على برهم».. إلى غير ذلك.
(مسألة ٢٥١): يجوز للولي تأديب الصبي وضربه بما يراه صلاحاً له. نعم لابد من الاقتصار على مقدار الحاجة والتدرج في ذلك مع كمال التروي والتعقل، وعدم الزيادة عن الحاجة تشفياً وانتقاماً أو استهواناً بأمر الصبي لضعفه. كما لابد من الحذر من اختلاط النظر لمصلحة الصبي بالانفعال النفسي منه، أو من المؤثرات الخارجية الاُخرى. وقد ورد في الاخبار الترخيص بخمس أو ست ضربات مع الحث على الرفق، فاللازم عدم الزيادة عليها إلا عند الحاجة والضرورة.
(مسألة ٢٥٢): لا يجوز لغير الولي ضرب الطفل بغير إذن الولي. ولو توقف دفع ضرره على ضربه وتعذر الرجوع للولي لزم الرجوع للحاكم الشرعي، ومع تعذر الرجوع إليه يتعين الاقتصار على ما لابد منه لدفع شره وضرره من دون إضرار به مهما أمكن.
(مسألة ٢٥٣): يجوز ضرب الصبي بإذن الولي وحينئذٍ إن كان الاذن مستفاداً من شاهد الحال - كوضع الصبي عند المعلم الظاهر في الاذن له بتأديبه بالوضع المتعارف - لزم الاقتصار عند الحاجة على ثلاث ضربات وعدم الزيادة على ذلك إلا بعد مراجعة الولي وشرح الحال له والتعاون معه. وإن كان الاذن مستفاداً بالتنصيص لزم الرجوع لما يقتضيه الاذن سعة وضيقاً مع عدم تعدي الولي عن مقتضى وظيفته المتقدمة.
(مسألة ٢٥٤): لابد من الحذر من الاضرار بالصبي عند تأديبه بمثل الجرح والكسر والعيب. ولو حصل شيء من ذلك كان مضموناً بالدية. وكذا الحال في الضرب من دون حاجة أو مع الزيادة عليه.
الفصل العاشر
في النفقات
ومحل الابتلاء منها أقسام..
الأول: نفقة الزوجة.
وهي تختص بالزوجة الدائمة وإن كانت أمة أو ذمية. ولا تجب للمتمتع به، ولو شرطت في العقد المنقطع فإن رجع الشرط إلى وجوب النفقة بنفس الزواج المنقطع بطل، بل الأحوط وجوباً حينئذٍ بطلان العقد أيض. وإن رجع إلى وجوبها بالشرط الذي تضمنه صح، ووجبت النفقة على حسب الشرط.
(مسألة ٢٥٥): تجب النفقة على الزوجة وإن كانت صغيرة، إلا إذا ابتنى الزواج بها على عدم الانفاق عليها ما دامت صغيرة غير قابلة للاستمتاع أو للوطء، بأن اُخذ ذلك شرطاً في العقد صريحاً أو ضمناً مستفاداً من شاهد الحال ولو بسبب تعارف ذلك.
(مسألة ٢٥٦): لا يشترط في وجوب نفقة الزوجة فقره، بل يجب الانفاق عليها وإن كانت غنية.
(مسألة ٢٥٧): يسقط وجوب النفقة على الزوجة بنشوزها على الزوج بأحد أمرين..
الأول: منعه عن حقوقه التي عليها من وجوه الاستمتاعات - غير الوطء في الدبر - والتزين الذي يريده منه، وعدم المنفرات له - ولو مثل سبه وشتمه والاعراض عنه وسوء معاشرته - مع حفظه في ماله وعرضه وعدم خيانته فيهم.
الثاني: الخروج من بيت زوجيتها بغير إذن الزوج، الذي تقدم في
المسألة(١٨٨) حرمته عليه. نعم لو كان خروجها لضرورة مسوغة لم تسقط النفقة. وكذا لو كان خروجها بإذنه، إلا أن يبتني إذنه لها على عدم النفقة لها حين الخروج، كما يتعارف في الاذن لها بالذهاب إلى أهلها أو غيرهم لتكون في ضيافتهم ومنه ما يتعارف من رضاه ببقائها عند أهلها أو في بيتها من حين العقد عليها إلى حين زفافها له ومجيئها إلى بيته.
(مسألة ٢٥٨): المطلقة رجعياً بحكم الزوجة، فتجب لها النفقة على زوجها ما دامت في العدة، وكذا المطلقة بائناً إذا كانت حاملاً منه. ولا تجب لها النفقة إذا كان حملها من غيره، أو لم تكن حامل، كما لا تجب النفقة للمعتدة غير المطلقة على صاحب العدة وإن كانت حاملاً منه كالمتمتع بها والمنسوخ نكاحها والموطوءة شبهة والملاعنة.
(مسألة ٢٥٩): المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها من تركة زوجها وإن كانت حامل.
(مسألة ٢٦٠): النفقة الواجبة للزوجة هي الطعام - مطبوخاً إن احتاج للطبخ - والشراب، والكسوة - مخيطة إن احتاجت للخياطة - بالوجه المتعارف، والسكن حيث يسكن الزوج حسب قدرته وطاقته مفروشاً بالوجه المتعارف، كما يجب عليه أن يبذل لها فراش النوم في ليلته معه، بل مطلقاً على الأحوط وجوب.
وأما الزينة والتنظيف ونحوهما فإن طلبها الزوج كان عليه بذل مؤنتها وإن لم يطلبها لم يكلف به، إلا مؤنة غسل الجنابة المسببة عنه فإن الأحوط وجوباً له بذله، كما يجب عليه بذل مصاريف الحمل والولادة بالمقدار الذي يحفظ به الولد، ويدخل في نفقة الولد لا نفقة الزوجة. ولا يكلف بما زاد على ذلك له، إلا مع التوافق بينهما فيبذل لها ما تحتاج إليه، بل يوسع عليها ويزيد في رفاهه، وتقوم هي بما يحتاج إليه من خدمة البيت وإدارته ورعاية الاطفال وغير ذلك، وبذلك تتم سعادة العائلة ويصلح أمره.
(مسألة ٢٦١): إذا توقف سد حاجاتها التي تتضرر بتركها على الخروج من البيت للعمل أو الاسترفاد كان لها ذلك، لكن تحاول - مهما أمكن - أن يكون الخروج بنحو لا ينافي حقه، وليس له منعها إلا أن يقوم بسد حاجاتها بنفسه لتستغني عن الخروج.
(مسألة ٢٦٢): إذا لم ينفق الزوج على زوجته - قصوراً أو تقصيراً - ففي بقاء النفقة ديناً عليه إشكال، والاظهر العدم، إلا أن تنفق على نفسها بقصد الرجوع عليه - على ما يأتي - وكذا إذا لم تستوف الزوجة نفقتها منه مع بذله لها تسامحاً منها أو لانفاقها على نفسها من مالها أو مما يبذله غير الزوج له، حتى لو لم يرجع ذلك منها إلى إسقاطها النفقة عن الزوج وإبراء ذمته منه، فإنه في جميع ذلك لا تبقى النفقة ديناً على الزوج، وهكذا الحال في نفقة الارحام.
(مسألة ٢٦٣): إذا كان للزوج مال وجب عليه الانفاق منه مع التمكن ولو بالاستدانة عليه. وإن لم يكن له مال، وجب عليه التكسب بتجارة أو عمل أو نحوهم.
(مسألة ٢٦٤): إذا لم يكن للزوج مال وتعذر عليه التكسب أو لزم منه الضرر أو الحرج فالأحوط وجوباً له الاستدانة إن علم بقدرته على الوفاء من مال يأتيه، وإن لم يعلم بذلك لم تجب الاستدانة حتى لو كان قادراً على الاسترفاد والاستيهاب، وطلب الحقوق والصدقات ونحوها مما يفي دينه.
(مسألة ٢٦٥): إذا لم ينفق الزوج على زوجته فإن أنفق عنه غيره عليها فذاك، وإلا كان لها أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي مطالبة بأحد أمرين..
الأول: النفقة، فيلزمه بالانفاق عليه، فإن امتنع وكان له مال أنفق عليها منه.
الثاني: الطلاق، فيأمره بطلاقها فإن تعذر أمْرُه بذلك أو امتنع من طلاقها طلقها الحاكم وليس على الحاكم حينئذٍ إلزام الزوج بالانفاق، أو الانفاق عليه
من ماله وإن أمكن ذلك. نعم إذا كان عدم إنفاق الزوج لمانع خارجي من مرض أو حبس أو نحوهما مع إمكان الانفاق عليها من ماله فالظاهر عدم مشروعية الطلاق، بل ينفق عليها من ماله حينئذٍ إن طلبت ذلك.
هذ، ويستثنى من ذلك المفقود، على ما يأتي في أول كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى.
الثاني: نفقة الارحام.
يجب الانفاق على الاولاد وإن نزلو. وعلى الابوين، بل الأحوط وجوباً الانفاق على آبائهما واُمهاتهم. ولا يجب الانفاق على غيرهم من الارحام، حتى الوارث الصغير، وإن كان أحوط استحباب. نعم تستحب النفقة عليه و على الارحام قاطبة.
(مسألة ٢٦٦): إنما تجب النفقة على الارحام مع فقرهم، ولا تجب مع غناهم ولو بقدرتهم على التكسب اللائق بهم. ولا يكفي قدرتهم على أخذ الحقوق - من الاخماس والزكوات - والصدقات والهبات، نعم مع بذل ذلك فعلاً من دون مهانة ولا حرج ففي وجوب الانفاق حينئذٍ إشكال، وإن كان أحوط وجوب.
(مسألة ٢٦٧): إنما تجب النفقة على الارحام مع القدرة، ولو بالقدرة على التكسب أوالاستدانة على مال موجود عنده، ولا تجب الاستدانة في غير ذلك، وإن كان قادراً على الوفاء من مال يأتيه، كما لا يجب الاسترفاد والتعرض لطلب الحقوق والصدقات ونحوه.
(مسألة ٢٦٨): الواجب من النفقة للارحام هو الطعام والشراب واللباس والاسكان والدواء وسائر ما يحتاجون إليه لمعاشهم، ولا يجب عليه ما عدا ذلك من حوائجهم، كوفاء الديون التي عليهم لله تعالى أو للناس وكتزويجهم.
(مسألة ٢٦٩): يختص الاب بالنفقة على الولد مع قدرته، دون الاُم، ودون الجد والجدة للاب والاُم. ومع فقده أو عجزه أو امتناعه - بحيث يتعذر الانفاق من ماله - ففي وجوب الانفاق عليهم كفايةً أو توزيع النفقة عليهم أو الترتيب بينهم إشكال، واللازم الاحتياط. نعم مع عدم الانفاق من بعضهم وتعذر الانفاق من ماله يتعين الانفاق على الباقين، ولا يبقى الولد بلا نفقة.
(مسألة ٢٧٠): إذا كان لمن يحتاج النفقة أب وولد ففي وجوب الانفاق عليه على أبيه أو عليهما معاً كفايةً أو بنحو التوزيع إشكال، واللازم الاحتياط، ومع عدم الانفاق عليه من أحدهما يتعين على الآخر الانفاق عليه ولا يبقى بلا نفقة، نظير ما تقدم في المسألة السابقة.
(مسألة ٢٧١): إذا امتنع المكلف بالنفقة من الانفاق كان لمن تجب النفقة له - من الارحام أو الزوجة - أولوليه المطالبة بالانفاق عليه وإجباره على ذلك، والأحوط وجوباً رفع أمره للحاكم الشرعي ليجبره على الانفاق، وإن تعذر إجباره على الانفاق وكان له مال اُنفق عليه منه، وإن تعذر ذلك أيضاً جاز الانفاق عليه بقصد الرجوع على من تجب عليه النفقة إن كان له مال ويكون ذلك حينئذٍ ديناً عليه. وإن تعذر الرجوع للحاكم جاز لمن له النفقة أولوليه تولي ذلك كله ولو بالاستعانة بالغير.
ويجري ذلك كله في حق غير الممتنع ممن يكلف بالنفقة ولا ينفق، كالمسافر والمسجون والغائب إذا تعذرت مراجعتهم.
(مسألة ٢٧٢): نفقة النفس مقدمة على نفقة الغير، إلا أن يكون واجب النفقة على غيره ولم يكن الغير ممتنعاً عنها فالأحوط وجوباً حينئذٍ له أن ينفق على من تجب عليه نفقته ويأخذ هو نفقته ممن تجب عليه.
(مسألة ٢٧٣): نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الاقارب، ونفقة الاقرب
منهم مقدمة على نفقة الابعد، فالولد مقدم على ولد الولد، فإن تساووا وعجز عن الانفاق عليهم نفقةً تامة تخير بين أن ينفق على بعضهم نفقة تامة ويترك الآخر وأن ينفق عليهم جميعاً بعض النفقة الواجبة بنحو التوزيع، إلا أن لا ينتفع بعضهم بالتوزيع فيتعين الاول. وإذا كان بعضهم واجب النفقة على غيره أيضاً ولم يكن الغير ممتنعاً عنها فالأحوط وجوباً إيكاله لذلك الغير والانفاق على الآخر.
الثالث: نفقة المملوك.
تجب النفقة للانسان المملوك، لكن لما لم كن مورداً للابتلاء غالباً في زماننا فلا نطيل الكلام ببيان فروعه. كما تجب النفقة على الحيوان المملوك، ولو بتركه يرعى بنفسه، ومع تعذر ذلك فالأحوط وجوباً بيعه أو ذبحه.
(مسألة ٢٧٤): نفقة الزوجة تقبل الاسقاط تبرعاً أو بالمصالحة عن شيء من الزوج يقوم به له، من دون فرق بين نفقة اليوم وما زاد عليه. أما نفقة الاقارب والمملوك فلا تقبل الاسقاط.
(مسألة ٢٧٥): تستحب النفقة على الارحام غير من تقدم. وفي الحديث عن الامام الصادق (عليه السلام): «من عال ابنتين أو اُختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار بإذن الله».
(مسألة ٢٧٦): يستحب التوسعة على العيال، وقد ورد الحث والتأكيد على ذلك عن المعصومين (عليهم السلام) ، ففي صحيح أبي حمزة عن الامام السجاد (عليه السلام): «أرضاركم عند الله أسبغكم[أوسعكم]على عياله»، وفي حديث مسعدة: «قال لي أبو الحسن (عليه السلام): إن عيال الرجل اُسراؤه، فمن أنعم الله عليه بنعمة فليوسع على اُسرائه، فإن لم يفعل أوشك أن تزول النعمة». نعم ينبغي ملاحظة اُمور..
الأول: عدم الافراط في ذلك، بنحو يؤدي للترف والبطر، فعن الامام زين العابدين (عليه السلام): «لينفق الرجل بالقسط وبلغة الكفاف، ويقدم منه الفضل
لآخرته، فإن ذلك أبقى للنعمة وأقرب إلى المزيد من الله وأنفع في العاقبة»، على أن عواقب ذلك وخيمة عليهم في سلوكهم وخلقهم وتكوين شخصيتهم ومستقبل حياتهم.
الثاني: عدم الاستهوان بالمال بتضييعه هدراً أو صرفه بمصارف تافهة، فعن الامام الصادق (عليه السلام): «إن القصد أمر يحبه الله عزوجل، وإن السرف أمر يبغضه الله عزوجل، حتى طرحك النواة فإنها تصلح لشيء، وحتى صبك فضل شرابك»، وفي حديث إسحاق بن عمار: «قلت لابي عبد الله (عليه السلام): يكون للمؤمن عشرة أقمصة؟ قال: نعم. قلت: عشرون؟ قال: نعم. قلت: ثلاثون؟ قال: نعم، ليس هذا من السرف، إنما السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك».
الثالث: الموازنة بين الدخل والمصروف، فعن الامام الصادق (عليه السلام) أنه قال: «رب فقير هو أسرف من الغني، إن الغني ينفق مما اُوتي، والفقير ينفق من غير ما اُوتي».
وعلى المؤمن أن يكون حكيماً في ذلك وفي جميع اُموره، فالحكمة فوق كل شيء. ومنه سبحانه نستمد التوفيق والتسديد.
والحمد لله رب العالمين
كتاب الطلاق
وما اُلحق به
الطلاق أمر شرعه الله تعالى رأفة بالناس وحلاً لمشاكلهم، على بغض منه تعالى له، لما فيه من تقويض بيت الزوجية - الذي هو أحب شيء إليه تعالى - وهدم كيان العائلة وتشتيت شمله، فعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «ما من شيء أحب إلى الله عزوجل من بيت يعمر بالنكاح، وما من شيء أبغض إلى الله عزوجل من بيت يخرب في الاسلام بالفرقة»، وعن الامام الصادق (عليه السلام) أنه قال: «ما من شيء مما أحله الله أبغض إليه من الطلاق».
فينبغي للمؤمنين أعزهم الله تعالى أن يتجنبوه ما وسعهم ذلك بالصبر والاناة والحكمة ومحاولة حل المشاكل أواستيعابها وتخفيفه، حتى إذا بقيت عقدة الزواج سبباً لانتهاك حدود الله تعالى وتعدي أحد الزوجين على الآخر وعيش العائلة وسط جحيم الشقاق والمشاكل المعقدة فليلجؤوا حينئذٍ لابغض الحلال الذي منَّ الله تعالى به عليهم لحل مشكلتهم، قال تعالى:(وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته) وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «خمس لا يستجاب لهم: رجل جعل بيده طلاق امرأته وهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يخل سبيله...».
والكلام في الطلاق وما اُلحق به في ضمن فصول..
الفصل الاول
في حقيقة الطلاق وصيغته ومالكه
الطلاق إيقاع يتضمن فرقة بعد النكاح الدائم دون غيره من أقسام النكاح، فيكفي فيه الايجاب ممن يملكه، ولا يحتاج إلى قبول من أحد. وهو بيد الزوج وأمره إليه ينفرد به، ولا يشاركه فيه غيره، وله أن يطلق متى شاء حتى لو كانت الزوجة موافقة، وإن كان ذلك مكروهاً كراهة شديدة.
نعم يقوم مقام الزوج غيره في موارد..
الأول: ما إذا لم ينفق الزوج على الزوجة، كما تقدم تفصيل الكلام فيه في فصل النفقات من كتاب النكاح.
الثاني: ما إذا ظاهر الزوج على ما يأتي في فصل الظهار.
الثالث: ما إذا فقد الزوج، فإنها إن صبرت بقيت على الزوجية حتى يعلم موته أو طلاقه، وكذا إذا كان للزوج مال فأنفق منه وليه عليه، أو أنفق الولي عليها من ماله، فإنه يجب عليها الصبر حينئذٍ. وإن لم يكن له مال ولم ينفق الولي عليها كان لها رفع أمرها للحاكم الشرعي، فيؤجلها إلى مضي أربع سنين من غيبته، ولابد من الفحص عنه هذه المدة في البلاد التي علم ذهابه لها وفقد فيه. وإن لم يعلم له بلد خاص فقد فيه فحص عنه في جميع البلاد التي يحتمل وجوده فيه، فإن علم حياته صبرت، وإن علم موته اعتدت عدة الوفاة من حين يبلغها الخبر، كما يأتي في مباحث العدد، وإن جهل خبره أمر الحاكم وليّه - وهو أقرب الناس إليه ممن يقوم مقامه ويتولى اُموره - أن يطلقه، فإن أبى أو لم يكن له ولي
طلقها الحاكم، ثم اعتدت بقدر عدة الوفاة من حين طلاقه، فإذا انقضت عدتها كان لها أن تتزوج.
(مسألة ١): الطلاق المذكور رجعي ولا يجب فيه الحداد، فإذا قدم الزوج في أثناء العدة المذكورة كان له الرجوع به، وإن قدم بعد انقضائها فقد بانت منه وليس له عليها رجعة.
(مسألة ٢): في عموم المفقود لمن فقد في بلده واحتمل عدم خروجه منه إشكال، والظاهر عدم جريان الحكم المتقدم عليه، بل يتعين على زوجته حينئذٍ الانتظار حتى يبلغها عنه موت أو طلاق.
(مسألة ٣): الظاهر الاجتزاء بالفحص قبل أن ترفع أمرها للحاكم، سواءً كان منها أم من غيره، فإن الحاكم يجتزئ به إذا علم باستيعابه وأنه لا يتيسر له الفحص زائداً عنه. وكذا الحال لو كان الفحص من الحاكم نفسه، كما لو كان للمفقود أكثر من زوجة فرفعت إحداهن أمرها له ففحص عنه، فإن الظاهر اجتزاؤه به لباقي زوجاته عند رفع أمره، ولا يحتاج إلى تكرار الفحص.
(مسألة ٤): إذا تعذر الفحص عن المفقود لم يشرع الطلاق ووجب على المرأة الانتظار.
(مسألة ٥): إذا علم بعدم وجوده في البلاد التي فقد فيها ولم يعلم موته فيها أو خروجه منها لغيرها لم يجب الفحص عنه لا في البلاد التي فقد فيها ولا في غيره.
الثالث: ما إذا كان الزوج معتوهاً ناقص العقل، فإنه يطلق عنه وليه مع حاجته لذلك، وكذا المجنون المطبق الذي لا يتوقع زوال جنونه. أما الادواري أومن يتوقع زوال جنونه فلا يطلق الولي عنه، بل ينتظر دور إفاقته وزوال جنونه، إلا مع الضرورة الملحة للتعجيل بحيث يعلم برضا الشارع الاقدس
بالطلاق لو فرض تحقق ذلك. وكذا الحال في الصبي، فإنه ينتظر بلوغه إلا مع الضرورة بالوجه المذكور فيطلق عنه وليه، والأحوط وجوباً مراجعة الحاكم الشرعي حينئذٍ، فلا يطلق الولي إلا بإذنه.
(مسألة ٦): يجوز لمن يملك الطلاق أن يأذن لغيره في إيقاعه عنه، أو يوكله في ذلك، فينفذ طلاقه حينئذٍ، وإن كانا معاً حاضرين في مجلس الطلاق.
(مسألة ٧): إذا ادّعى غير الزوج الوكالة على الطلاق أو الولاية عليه لم يقبل منه، ولو أوقع الطلاق لم يترتب عليه الاثر ظاهر، إلا أن يثبت بعد ذلك سلطنته عليه، ولو بأن يصدق من له الولاية على الطلاق الوكيل في دعوى الوكالة.
(مسألة ٨): يجوز توكيل الزوجة على طلاق نفسها وينفذ طلاقها حينئذٍ، بل لها أن تشترط في عقد النكاح الوكالة في الطلاق، كما تقدم في آخر الفصل السادس من كتاب النكاح.
(مسألة ٩): لا يصح طلاق الفضولي، وهو الذي ليس له السلطنة على الطلاق، ولا يصححه بعد وقوعه إجازة من له السلطنة عليه.
(مسألة ١٠): صيغة الطلاق أن يقول: فلانة طالق، أو أنت طالق، أو زوجتي طالق، أو نحو ذلك مما يتضمن تعيين الزوجة المطلَّقة مع المحافظة على الهيئة المذكورة. ولا تجزئ مادة الطلاق مع اختلاف الهيئة، كما لو قال: طلقتك، أو أنت مطلقة، أو نحو ذلك.
(مسألة ١١): إذا قال: أنت طالق ثلاث، أو اثنتين فلا يقع العدد المذكور. وفي حصول طلقة واحدة به إشكال.
(مسألة ١٢): لا يقع الطلاق بالكنايات من دون أن تشتمل على مادة الطلاق، مثل: أنت حرام، أو بائنة، أو خليّة. وفي وقوعه بقوله: اعتدّي، إذا نوى به إنشاء الطلاق إشكال، والأحوط وجوباً العدم.
(مسألة ١٣): إذا قيل للزوج: هل طلقت زوجتك؟ فقال: نعم، لم يقع بذلك طلاق، سواءً قصد بقوله: (نعم) إنشاء الطلاق أم الاخبار عنه. غاية الامر أنه إذا قصد الاخبار كان إقراراً بالطلاق فيلحقه حكم الاقرار.
(مسألة ١٤): لا يقع الطلاق بغير العربية إلا مع تعذر العربية على المطلِّق، فيطلق بلغة اُخرى، ولا يحتاج للتوكيل.
(مسألة ١٥): لا يقع الطلاق بالكتابة، ولا بالإشارة إلا مع تعذر النطق على المطلق لخرس أو نحوه، فيجزئه الطلاق بالكتابة، بأن يكتب بقصد إنشاء الطلاق ويُشهِد على ذلك مع مراعاة شروط الطلاق الاُخرى، ومع عجزه عن الكتابة يكتفي بالإشارة المُفهمة بقصد إنشاء الطلاق أيض، مثل أن يضع ثوباً على رأسها كأنها صارت أجنبية عنه.
(مسألة ١٦): لا أثر لتخيير الزوج زوجته، حتى لو كان بقصد إنشاء الطلاق، كما لا أثر لاختيارها نفسها بعد التخيير المذكور. نعم إذا رجع التخيير المذكور إلى الاذن لها في طلاق نفسها فطلقت نفسها على النحو المأذون فيه صح طلاقه. ولابد حينئذٍ من حصول شروط الطلاق حال طلاقها لنفسه، لا حال تخيير الزوج له.
الفصل الثاني
في شروط الطلاق
وهي اُمور..
الأول: البلوغ، فلا يصح طلاق الصبي، وإن بلغ عشر سنين وطلق للسنة.
الثاني: العقل، فلا يصح طلاق المجنون والسكران ونحوهم.
الثالث: الرشد، فلا يصح طلاق المعتوه ونحوه.
الرابع: عدم الاكراه، فلا يصح طلاق المكرَه وإن رضي بعد ذلك.
(مسألة ١٧): يكفي في الاكراه وقوع الطلاق من دون رضىً به، بل مداراة للغير كالابوين والزوجة ونحوهم. أما إذا أوقع الطلاق راضياً به لتجنب مشاكل الآخرين فليس ذلك من الاكراه ويصح الطلاق حينئذٍ.
الخامس: القصد إلى إنشاء الطلاق بالصيغة، فلا يصح طلاق الغالط والساهي والهازل ونحوهم، كما لا يقع الطلاق إذا تلفظ بالصيغة لا بقصد إنشاء الطلاق، بل لمجرد إرضاء الغير مثل. وكذا إذا تلفظ بها بنية الاخبار عن الطلاق لا إنشائه. غايته أنه يكون إقراراً بالطلاق فيلحقه حكم الاقرار.
السادس: أن يكون منجَّز، فلا يصح الطلاق المعلَّق، سواءً علّقه على التزويج، كما لو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أم على أمر آخر، كما لو قال: إن خرجت من بيتها فهي طالق، أو نحو ذلك. والأحوط وجوباً عموم ذلك لما إذا علّقه على أمر معلوم الحصول، أو محتمل الحصول، مقوِّماً لصحة الطلاق، كما لو قال: إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق، أو إن كانت زوجتي طاهراً فهي طالق.
السابع: تعيين المطلقة ولو إجمال، كما لو قال: أكبر نسائي طالق، بخلاف ما لو كانت مردَّدة من كل وجه، كما لو قال: إحدى نسائي طالق، فإنه لا يقع حينئذٍ.
الثامن: أن يقع حال كون المرأة المطلقة في طهر لم يجامعها فيه، فلا يصح طلاقها حال الحيض أو النفاس، ولا في طهر قد جامعها فيه. بل الظاهر عدم صحة طلاقها في النقاء المتخلل بين الدمين في الحيض الواحد وإن كان بحكم الطهر.
(مسألة ١٨): لو طلق جاهلاً بحالها لم يقع الطلاق ظاهر، إلا أن ينكشف كونها في طهر لم يواقعها فيه، فينكشف صحته.
(مسألة ١٩): إذا شك في الحيض بعد العلم بالطهر بني على عدم الحيض، وإذا علم بدخولها في الحيض وشك في طهرها منه بني على بقائه
في الحيض. لكن إذا أخبرت بأنها حائض صدّقت، وكذا إذا أخبرت بأنها قد دخلت في الطهر الذي لم يجامعها فيه.
نعم إذا أخبرت بأنها دخلت في طهر لم يجامعها فيه فطلقها ثم أخبرت بأنها كانت كاذبة في خبرها لم يقبل منه، وحكم بصحة الطلاق، إلا أن يعلم بصدقها في خبرها الثاني أو تقوم به البينة.
(مسألة ٢٠): الغائب عنها زوجها إن عَلِم حالَها فهو كالحاضر يجري عليه الحكم السابق، وكذا إن جَهله وتيسر له الفحص عنه. أما إذا صعب عليه الفحص فيجوز له طلاقه، لكن الافضل أن ينتظر شهراً من سفره. بل لو كان سفره حال حيضها فليكن مبدأ الشهر بعد مضي مدة حيضها الذي فارقها عليه. والافضل للغائب أن ينتظرها ثلاثة أشهر، بل خمسة أو ستة.
(مسألة ٢١): المسترابة إذا كانت مدخولاً بها لا يطلقها زوجها إلا بعد مضي ثلاثة أشهر قمرية من آخر مرة واقعها فيه، من دون فرق في ذلك بين الحاضر والغائب. والمراد بالمسترابة من لا تحيض وهي في سن من تحيض، سواءً كان ذلك لعارض اتفاقي لها من مرض أو نحوه، أم بوجه يتعارف في أمثاله، كما لو كانت في أول بلوغها أو قاربت سن اليأس، أو كانت مرضعة.
(مسألة ٢٢): الحاضر إذا تعذر عليه معرفة حيض زوجته من طهرها - لتعذر الوصول إليها أو لامتناعها من الاخبار عن حالها أو لغير ذلك - فإن علم بأنها مستقيمة الحيض جرى عليه حكم الغائب، وإن احتمل كونها مسترابة لا تحيض أجرى عليها حكم المسترابة المتقدم.
(مسألة ٢٣): لا يشترط وقوع الطلاق في طهر لم يجامعها فيه في موارد..
الأول: أن تكون صغيرة لم تبلغ سن الحيض، بأن كانت دون التسع سنين قمرية، وإن كان قد جامعه.
الثاني: أن تكون قد بلغت سن اليأس، وهو في القرشية ستون سنة قمرية، وفي غيرها خمسون.
الثالث: الحامل المستبين حمله، بل مطلقاً على الاظهر، فإذا طلق الرجل زوجته في طهر قد جامعها فيه أو في حال الحيض - عمداً أو جهلاً - ثم تبين أنها حامل حين الطلاق انكشف صحة طلاقه له.
الرابع: غير المدخول بها قبلاً أو دبر، فإنه يصح طلاقها وإن كانت حائض.
(مسألة ٢٤): إذا جامع الرجل زوجته حال الحيض - عمداً أو جهلاً - صح منه طلاقها بعد طهرها من الحيض، ولا يشترط دخولها في طهر آخر.
(مسألة ٢٥): إذا شك في البلوغ بنى على عدمه، وكذا إذا شك في اليأس، أو في الحمل، أو في الدخول، ويجوز ترتيب الاثر على ذلك ظاهراً في الجميع، لكن لو ظهر الخطأ فالحكم تابع للواقع.
التاسع: الاشهاد، وذلك بأن يشهد الطلاق رجلان عادلان، بحيث يسمعانه إذا كان باللفظ، ويريانه إن كان بالإشارة ونحوها من الأخرس ونحوه.
(مسألة ٢٦): يشترط عدالة الشاهدين حين الطلاق ولا يبطله خروجهما عن العدالة بعده، كما لا يكفي عدالتهما بعد الطلاق إذا لم يكونا عادلين حينه.
(مسألة ٢٧): إذا أحرز من يتولى الطلاق - مباشراً كان أو موكَّلاً مفوضاً - عدالة الشاهدين حين الطلاق فطلق ثم ظهر منهما ما ينافي العدالة فإن كشف عن عدم عدالتهما حين إيقاع الطلاق انكشف بطلان الطلاق، وإن لم يكشف عن ذلك بل احتمل خروجهما عن العدالة بعد اتصافهما به، بني على صحة الطلاق. بخلاف ما إذا لم يحرز عدالتهما حين الطلاق، وأوقع الطلاق متردداً في حالهما وفي صحة الطلاق، فإنه لا يجوز البناء على صحة الطلاق حتى يعلم سبق العدالة منهما ووقوع الطلاق حينه.
(مسألة ٢٨): لا يكفي إحراز عدالة الشاهدين من قبل الوكيل على إجراء الصيغة فقط، بل لابد من إحراز عدالتهما من قبل موكله. نعم يكفي إحرازها من قبل الوكيل إذا كان مفوضاً إليه أمر الطلاق.
(مسألة ٢٩): تقدم في فصل شروط إمام الجماعة تحديد العدالة، والتعرض لكيفية إحرازه.
(مسألة ٣٠): لا يشترط في الشاهدين أن يعرفا الرجل المطلِّق أو المرأة المطلَّقة بعد أن كانت معينة في نفسه.
(مسألة ٣١): لا يشترط في الاشهاد أن يُطلَب من الشاهدين تحمل الشهادة، فلو فاجأهما بصيغة الطلاق كفى. نعم لابد من معرفتهما مراده بالصيغة أو بالإشارة التي تقوم مقامها من الأخرس ونحوه.
(مسألة ٣٢): لابد من أن يشهد الشاهدان إنشاء الطلاق، ولا يكفي أن يشهدا إقرار الزوج به إذا كان قد أوقعه من دون إشهاد. بل لابد من إنشائه مجدداً بشروطه المقررة أمامهم. ويترتب الاثر من حين الانشاء الذي وقع أمامهم.
(مسألة ٣٣): لا يشترط في شهادة الشاهدين حضور مجلس الطلاق، فلو سمعا الصيغة من بعيد صح الطلاق. وعلى ذلك يصح الطلاق لو سمعه الشاهدان بالهاتف أو المذياع إذا كانا يسمعان صوت المطلق بنفسه، أما إذا كانا يسمعان الصدى ففيه إشكال، وكذا إذا كانا يريان الإشارة - من الأخرس ونحوه - في الصورة التلفزيونية وإن كان البث مباشر. بل لا إشكال في عدم الصحة مع سماعه من التسجيل، أو رؤيته في الصور التلفزيونية إذا لم يكن البث مباشر.
(مسألة ٣٤): إذا طلقها وكيل الزوج فلابد من شاهدين غير الوكيل. وفي الاكتفاء بكون أحدهما الزوج الموكِّل أو وليه - إذا كان قد حضر وكان عادلاً - إشكال، والأحوط وجوباً العدم.
(مسألة ٣٥): لا يشترط في صحة الطلاق حضور المرأة المطلقة في مجلس الطلاق، ولا علمها به حين وقوعه، فضلاً عن رضاها به أو إذنها فيه.
(مسألة ٣٦): لابد من إحراز الشروط المتقدمة بالوجه المقرر شرعاً من قبل الزوج الموقع للطلاق أو وليه أو وكيلهما المفوض فيه، أما الوكيل على إجراء الصيغة فقط فلا يشترط إحرازه له، بل يكفي إحراز الموكِّل، ومع إحرازها يصح الطلاق ظاهراً ويعمل عليه. لكن لو انكشف الخطأ انكشف بطلان الطلاق وعدم ترتب الاثر عليه، وبقاء المرأة على الزوجية.
(مسألة ٣٧): إذا اُوقع الطلاق من دون إحراز للشروط من قبل المتولي له - المباشر أو الموكَّل على إجراء الصيغة فقط - لم يصح ظاهراً ولا يجوز ترتيب الاثر عليه، إلا أن يثبت بعد ذلك بالوجه الشرعي تحقق الشروط حين الطلاق.
هذا إذا كان المتولي للطلاق متردداً في صحة الطلاق حين إيقاعه بسبب عدم إحراز الشروط. أما إذا أوقعه جازماً بصحته غفلة عن لزوم إحراز الشروط، ثم احتمل تحقق الشروط وصحة الطلاق فالظاهر البناء على الصحة. لكن يحسن جداً الاحتياط حينئذٍ.
(مسألة ٣٨): إذا اُحرزت الشروط حين الطلاق ممن يجب عليه إحرازها ثم شك في صحة الطلاق لاحتمال الخطأ في إحراز الشروط بني على صحة الطلاق.
(مسألة ٣٩): إذا عُلم بإيقاع الطلاق ممن له السلطنة عليه وشك في صحته وفساده بني على الصحة.
(مسألة ٤٠): إذا أخبر من له السلطنة على الطلاق بإيقاع الطلاق قُبِل منه حتى لو كان بعد مضي زمان العدة، بأن ادعى أنه طلق قبل مدة تزيد على زمان العدة. وإذا شك حينئذٍ في صحته بني على الصحة. وكذا إذا عُلم بوقوع الطلاق وشك في صحته، ولا يجب الفحص والسؤال. نعم إذا علم بكذبه في إخباره أو
علم ببطلان الطلاق فلا مجال لترتيب الاثر عليه.
(مسألة ٤١): إذا وقع الطلاق بوجه صحيح عند بعض فقهائنا باطل عند آخر صح ظاهراً عند من يرى صحته من الفقهاء ومقلديهم، وبطل ظاهراً عند من يرى بطلانه من الفقهاء ومقلديهم، ولا يلزم الكل أحد الوجهين بعينه. وكذا الحال لو كان الاختلاف للاختلاف في الموضوع، كما لو كان الشاهدان عادلين عند بعض فاسقين عند آخر.
(مسألة ٤٢): إذا أوقع المتولي للطلاق الطلاق بوجه لا تراه المرأة صحيحاً لم يجز لها ترتيب الأثر عليه، وكان لها مطالبته بحقوق الزوجية، فإن امتنع رفعت أمرها للحاكم الشرعي، فينفذ عليهما حكم الحاكم ظاهر، فإن كان مطابقاً لما تراه المرأة كان للزوج التخلص بتجديد الطلاق، وإن كان مخالفاً له كان للحاكم تخليصها من مشكلتها بإلزامه بالنفقة، فإن أبى ألزمه بطلاقه، فإن أبى طلقها عنه. وكذا الحال إذا أخبر بالطلاق واعتقدت المرأة كذبه.
أما إذا انعكس الأمر بأن كان الطلاق ثابتاً أو صحيحاً عند المرأة وخالفها الرجل في ذلك، فإن ترافعا للحاكم فحَكَم للمرأة واعتقد الرجل بقاء الزوجية فليس عليه من حقوق الزوجية شيء لعدم مطالبتها بها وعدم تمكينها من نفسه. لكن ليس له ترتيب الاثر على عدم الزوجية - فلا يتزوج الخامسة مثلاً - إلا أن يطلق.
وإن حكم الحاكم للرجل نفذ الحكم على المرأة ووجب عليها التمكين مع المطالبة وحرم عليها ما زاد على ذلك. وينبغي لهما حينئذٍ حل مشكلتهما بما يناسب وضعهما معاً بتجديد العقد أو الطلاق، والبعد عن التعنت والمضارة أوالخروج عن الميزان الشرعي الثابت في حق كل منهم.
ويجري نظير ذلك لو اختلفا في حصول النكاح أو في صحته، كما يظهر بالتأمل.
(مسألة ٤٣): إذا طلق المخالف طلاقاً يصح في مذهبه ولا يصح عندنا لم يصح طلاقه واقع، فيجوز لزوجته المؤمنة أن تمكنه من نفسها لو لم يرتب هو الاثر على ذلك الطلاق. لكن لنا إلزامه بصحته، فيجور لزوجته إن كانت مؤمنة أن تتزوج من غيره بعد الخروج من العدة، ويصح زواجها حينئذٍ، كما يجوز للمؤمن أن يتزوج زوجته التي طلقها مؤمنة كانت أو مخالفة. وإن استبصر بعد أن تزوجت زوجته التي طلقها فلا سبيل له عليه، وإن استبصر قبل أن تتزوج فلا ينفذ الطلاق عليه، بل تبقى المرأة زوجة له على النحو الثابت عندن. أما المؤمن فإنه إذا طلق على مذهب المخالفين مخالفاً لما عندنا لم ينفذ طلاقه لا في حقه ولا في حقنا ولا يجوز إلزامه به.
(مسألة ٤٤): إذا طلق الكافر من غير أهل القبلة زوجته طلاقاً صحيحاً في دينه باطلاً عندنا فطلاقه نافذ عليه وعلى غيره مطلق، سواء بقي على دينه أم أسلم، وقد تزوجت المرأة أو لم تتزوج.
الفصل الثالث
في أحكام الطلاق
(مسألة ٤٥): الطلاق الفاقد للشرائط المتقدمة باطل لا يترتب عليه الاثر. وهو المعروف عند المسلمين بالطلاق البدعي.
(مسألة ٤٦): الطلاق الصحيح قسمان..
الأول: البائن، وهو الذي تخرج به المطلقة عن عصمة الزوج، فلا يشرع له الرجوع بها حتى لو كانت ذات عدة. وهو طلاق المرأة بعد بلوغها سن اليأس المتقدم، وطلاق الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين قمرية، وطلاق المرأة التي لم يدخل بها الزوج قبلاً ولا دبر. وطلاق الخلع والمباراة، على تفصيل يأتي
في محله إن شاء الله تعالى. والطلاق الثالث للحرة، والثاني للامة، على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.
الثاني: الرجعي، وهو الذي تبقى فيه المطلقة في عصمة الزوج فيشرع له الرجوع بها ما دامت في العدة، وهو ما عدا الاقسام السابقة.
(مسألة ٤٧): لا يشرع الطلاق بعد الطلاق من دون أن يتخلل بينهما رجوع، فإذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، صح الاول وبطل ما بعده.
(مسألة ٤٨): يصح الطلاق بعد الطلاق إذا تخلل بينهما الرجوع، وإن لم يتخلل بينهما المواقعة، بل وإن كانا في طهر واحد. فيصح طلاق المرأة ثلاثاً بينها رجوعان من دون مواقعة في طهر واحد، ويكون الثالث بائناً لا رجوع معه في العدة، وإن كان الاولى أن يكون لكل طلاق طهر. بل الاولى أن تحصل المواقعة بعد الرجوع، فيطلقها ثم يراجعها ويواقعه، وينتظر بها طهراً آخر، فيطلقها ثم يراجعها ويواقعه، وينتظر بها طهراً آخر، فيطلقها الطلاق الثالث. وهذا هو المعروف بطلاق العدة.
(مسألة ٤٩): إذا طلق الرجل المرأة ثلاثاً حرمت عليه في الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره، فيكون هو المحلل له، سواء كان الرجوع المتخلل رجوعاً من طلاق رجعي أم زواجاً بعقد جديد، بعد الخروج من العدة أو بعد طلاق بائن.
هذا في الحرة، أما الامة فإنّ زوجها إذا طلقها مرتين حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره. وحيث كان الابتلاء بذلك في عصورنا نادراً أو منعدماً فقد أعرضنا عن بقية أحكامه.
(مسألة ٥٠): من طلق امرأته طلاق العدة - الذي تقدم في آخر المسألة (٤)
ثم تزوجت غيره وحللها ثم طلقها وتزوجها الاول، ثم طلقها طلاق العدة المتقدم أيض، ثم تزوجت غيره وحللها ثم تزوجها الاول، ثم طلقها طلاق العدة
المتقدم أيض، فتمّ له طلاقها تسع تطليقات للعدة حرمت عليه مؤبد. والمشهور اختصاص التحريم المؤبد بذلك، فلا تحرم بغيره من أقسام الطلاق مهما بلغ. ولكن الأحوط وجوباً التحريم المؤبد بالطلاق التاسع مطلقاً وإن لم تكن التطليقات للعدة.
(مسألة ٥١): يشترط في الزوج المحلِّل للحرة بعد ثلاث تطليقات وللامة بعد تطليقتين اُمور..
الأول: أن يكون زواجه منها دائم، فلا يكفي الزواج المنقطع، فضلاً عن ملك اليمين أو وطء الشبهة.
الثاني: أن يكون بالغ.
الثالث: أن يدخل بها وإن لم ينزل. نعم لا اعتبار بزواج الخصي منها وإن دخل به.
الرابع: أن يكون الوطء في القبل، على الأحوط وجوب.
فإذا تمت هذه الشروط حصل التحليل، فإذا خرجت عن زوجيته بطلاق أو موت أو نحوهما حلّ للاول تزوّجه.
(مسألة ٥٢): المحلِّل المذكور كما يوجب سقوط حكم التطليقات الثلاث ويرفع التحريم الحاصل بها يرفع حكم التطليقة الواحدة والتطليقتين أيض، فمن طلق امرأته تطليقة واحدة أو تطليقتين ثم تزوجت غيره بالنحو المذكور وطُلّقت، فإذا تزوجها الاول لم تحرم عليه حتى يطلقها ثلاثاً بعد زواجه منه، ولا تحرم بطلاقها مرة أو مرتين.
(مسألة ٥٣): الرجوع إيقاع يتضمن الرجوع في الزوجية ورفع اليد
عن الطلاق، ولا يشترط فيه قول مخصوص، بل يقع بكل ما يدل عليه، مثل: رجعت بك، ورددتك، وأنت زوجتي، وغير ذلك مما يراد به الرجوع. بل يقع بالفعل المقصود به الرجوع، كما لو واقعها أو قبّلها بقصد الرجوع. أما لو فعل ذلك لا بقصد الرجوع فلا يتحقق به الرجوع إلا في المواقعة، فإنها تكون رجوعاً وإن لم يقصد بها الرجوع. نعم الأحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا واقعها ملتفتاً لكونها في العدة الرجعية، دون ما إذا نسي الطلاق أو تخيل أنها قد خرجت من العدة أو أن عدتها بائنة أو أنها امرأة اُخرى غير المطلقة، فيحتاط حينئذٍ بتجديد الرجوع أو الطلاق. بل لو لم يقصد المواقعة - كما لو كان نائماً أو ساهياً - أو واقع مكرهاً فالظاهر عدم حصول الرجوع، ولا يحتاج للاحتياط.
(مسألة ٥٤): إذا طلق بالشرائط ثم أنكر الطلاق قبل خروج العدة الرجعية كان إنكاره بحكم الرجوع، سواءً قصد به الرجوع، أم لم يقصد بأن وقع منه نسياناً للطلاق أو مكابرة فيه وكذب.
(مسألة ٥٥): لا يشترط في الرجوع المباشرة، بل يمكن التوكيل فيه فيقع من الوكيل بكل ما يدل على الرجوع ويقصد به.
(مسألة ٥٦): لا يشترط في الرجوع الاشهاد، نعم هو مستحب. ولو لم يشهد حين الرجوع استحب له الاشهاد بعده، بأن يقرّ أمام شاهدين عادلين بأنه قد سبق منه الرجوع.
(مسألة ٥٧): يقبل قول الرجل في الرجوع ما دامت المرأة في العدة، فإذا خرجت من العدة لم يقبل منه دعوى الرجوع في العدة إلا بالبينة. ولا يقوم مقام البينة شهادة رجل وامرأتين، ولا شهادة رجل واحد ويمين الزوج.
(مسألة ٥٨): إذا رجع الزوج في العدة وأشهد على ذلك، لكنه كان متستراً به وطلب من الشهود الكتمان، فلم يبلغ ذلك المرأة حتى خرجت العدة،
ففي صحة الرجوع حينئذٍ إشكال، واللازم الاحتياط.
(مسألة ٥٩): يكره للرجل الرجوع في الطلاق إذا لم يكن له بالمرأة حاجة، وكان رجوعه لأجل تجديد الطلاق. بل يستحب له تركها حتى تخرج من عدتها بالطلاق من دون رجوع، متحلياً بالصبر والاناة لتبقى لهما حرية الاختيار، لعل الله يحدث بعد ذلك أمر.
ولا ينبغي للمؤمن أن يسد على نفسه باباً فتحه الله تعالى له - توسعة عليه ورحمة به - في موقف انفعالي قد يدفع الشيطان له لا يستطيع بعد ذلك تداركه.
(مسألة ٦٠): يكره للمريض طلاق زوجته، فإن طلقها توارثا في العدة الرجعية مطلق، ولا يرثها هو في غيرها كما هو الحال في الصحيح. أما هي فترثه - وإن كان الطلاق بائناً - إلى سنة من حين الطلاق إلا في موارد..
الأول: أن يصح من مرضه قبل السنة ثم يموت.
الثاني: أن تتزوج بغيره بعد الخروج من العدة في أثناء السنة. أما الزواج منه - دواماً أو متعة - فلا يسقط ميراثها منه إلى السنة. بل لو كان دواماً ودخل بها ورثته حتى لو مات بعد السنة.
الثالث: أن يكون الطلاق بعد مراجعتها ورضاه، أو كان خلعاً أو مباراة. بل الظاهر عدم كراهة الطلاق منه حينئذٍ من حيثية المرض.
الفصل الرابع
في العدة
تجب العدة على المرأة باُمور..
الأول: وفاة الزوج.
الثاني: الخروج عن الزوجية - مع حياة الزوج - بأحد اُمور..
أولها: الطلاق في الزواج الدائم.
ثانيها: انقضاء الأجل أو هبة المدة في المنقطع.
ثالثها: فسخ النكاح بأحد العيوب المتقدمة.
رابعها: بطلان النكاح، كما لو أرضعت إحدى الزوجتين الاُخرى حتى صارت اُماً له، أو ارتد أحد الزوجين، على التفصيل المتقدم في بحث حرمة النكاح بالكفر، أو غير ذلك من أسباب البطلان.
الثالث: وطء الشبهة.
إذا عرفت هذا فعدة الوفاة تثبت مطلق، سواء كانا صغيرين أم كبيرين أم مختلفين، وسواء كانا مسلمين أم كافرين أم مختلفين، وسواء دخل بها أم ل.
أما غيرها فهي مشروطة بأمرين..
الأول: أن تكون المرأة في سن الحيض، فلا عدة على الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين قمرية، ولا على اليائسة التي خرجت عن سن الحيض ببلوغ ستين سنة قمرية في القرشية وخمسين في غيره.
الثاني: الدخول قبلاً أو دبر، فلا عدة على غير المدخول به. نعم الأحوط وجوباً مع دخول مني الرجل في فرج المرأة من غير وطء الجمع بين تكاليف المعتدة وغيره، فلا تتزوج في مدة العدة مثلاً ولا يرجع بها الزوج لو طلقه.
(مسألة ٦١): عدة الحرة المطلقة التي تحيض ثلاثة أطهار، وهي ما بقي من الطهر الذي طلقت فيه وطهران بعده، وتنتهي عدتها بأن ينزل عليها الدم من الحيضة الثالثة. فلها أن تتزوج حال الحيض حينئذٍ على كراهة، لكن يحرم عليها أن تمكن زوجها من وطئها حتى تطهر.
(مسألة ٦٢): تعتد الكافرة الحرة المطلَّقة بثلاثة أطهار من حين طلاقها إذا أسلمت قبل مضي طهرين من طلاقه، بل وإن لم تسلم على الأحوط وجوب.
(مسألة ٦٣): تعتد الامة المطلقة بطهرين، وتخرج عن العدة بنزول الدم من الحيضة الثانية، إلا أن تعتق قبل ذلك فتتم عدة الحرة.
(مسألة ٦٤): إنما يحسب الطهر الذي وقع فيه الطلاق من العدة إذا بقي منه شيء بعد الطلاق. أما إذا كان الطلاق في آخر الطهر بحيث كان التحيض مقارناً للفراغ من الطلاق فلا يحسب ذلك الطهر من العدة، بل تبدأ العدة بالطهر الذي يكون بعد ذلك الحيض.
(مسألة ٦٥): عدة المتمتع بها التي تحيض طهران، فإن خرجت عن الزوجية - بانتهاء المدة أو هبتها - في طهر كان عليها إكماله وإكمال الطهر الثاني فتخرج عن العدة بالحيضة الثانية، وإن خرجت عنها في آخر الطهر أو في أثناء الحيض كان عليها إكمال طهرين، فتخرج عن العدة بالثالثة.
(مسألة ٦٦): تقدم في فصل شروط الطلاق أن المسترابة - وهي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض - لا تطلق إلا بعد أن تستبرأ بأن يعتزلها الزوج ولا يطأها ثلاثة أشهر، فإذا طلقها وكانت حرة فعدتها ثلاثة أشهر قمرية ولو
ملفقة، وإن كانت أمة فعدتها شهر ونصف.
(مسألة ٦٧): عدة المتمتع بها إذا كانت مسترابة شهر ونصف.
(مسألة ٦٨): لا فرق في التي لا تحيض وهي في سن من تحيض بين من يتعارف ذلك منها في سنها - كالمرأة في أول بلوغها وفي آخر أيام حيضهاومن يتعارف ذلك منها لرضاع ونحوه، ومن ينقطع حيضها لعارض خاص من مرض أو نحوه. نعم إذا احتمل أن انقطاع حيضها للحمل فإنها تنتظر أقصى الحمل من حين المواقعة الاخيرة، وهو سنة، فإن ظهرت حاملاً وإلا انكشف أن عدتها ثلاثة أشهر أو شهر ونصف.
(مسألة ٦٩): من تحيض كل ثلاثة أشهر أو أقل أو أكثر إن كان طلاقها في أول الطهر فمضى لها ثلاثة أشهر بيض لم تر فيها دماً كانت عدتها الاشهر المذكورة لا غير. وإن كانت ترى الدم في أقل من ثلاثة أشهر فلا يتم لها طهر ثلاثة أشهر كانت عدتها ثلاثة أطهار. وإن كانت أطهارها مختلفة بالطول والقصر تعتد إلى أسبق الامرين من ثلاثة أشهر بيض وثلاثة أطهار، فأيهما سبق تمت به عدته. وعليه قد تكون عدتها مركبة من طهر أو طهرين وثلاثة أشهر بيض.
نعم إذا كانت شابة مستقيمة الحيض، فلم تحض في ثلاثة أشهر إلا حيضة واحدة، ثم انقطع حيضها وجهل سببه، فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلاقه، ثم تعتد بثلاثة أشهر، فتكون عدتها سنة.
(مسألة ٧٠): من كانت عدتها طهرين أو شهراً ونصفاً - كالمتمتع بها والامة المطلقة - إذا كانت تحيض كل ثلاثة أشهر أو أكثر أو أقل فالظاهر أن عدتها طهران، ولا تعتد بشهر ونصف أبيض لو سبق لها قبل إكمال الطهرين.
(مسألة ٧١): المستحاضة التي يستمر بها الدم تمام الشهر ترجع في تعيين أيام حيضها إلى ما تقدم في مبحث الحيض من كتاب الطهارة، فلا تطلق فيه، بل
تطلق في الايام المحكومة بأنها طهر. والأحوط وجوباً أن لا تتحيض بالاطهار إن كانت حرة مطلّقة، بل بثلاثة أشهر، خصوصاً إذا كانت تتحيض بالعدد، لعدم كونها ذات عادة سابقة، ولا ذات تمييز وليس وظيفتها الرجوع لاقاربه.
أما إذا كانت متمتعاً بها أو أمة مطلقة فالأحوط وجوباً أن تعتد بأبعد الأجلين من الطهرين والشهر والنصف، فإذا بدأت عدتها في أول الطهر تكمل الطهر الثاني ولا تكتفي بشهر ونصف، وإذا بدأت عدتها بأواخر الطهر تكمل شهراً ونصفاً ولا تكتفي بإكمال الطهر الثاني.
(مسألة ٧٢): الأحوط وجوباً في التي تحيض في الشهر مراراً أن تعتد بأبعد الأجلين وهو الشهور، فتعتد بثلاثة شهور إن كانت حرة مطلقة، وبشهر ونصف إن كانت متمتعاً بها أو أمة مطلقة.
(مسألة ٧٣): المطلقة الحرة إذا كانت صغيرة وهي في سن من تحيض فاعتدت بشهر ثم حاضت لم يحسب الشهر من عدته، بل تستأنف عدتها بالاطهار فتعتد بثلاثة أطهار بعد الحيض الذي وقع عليه. وهو الأحوط وجوباً في كل من تكون عدتها بالشهور إذا فجأها الحيض قبل إكمال عدته.
(مسألة ٧٤): من تكون عدتها بالاطهار إذا بدأت عدتها بطهر أو طهرين ثم انقطع حيضها تلغي الاطهار ثم تستأنف عدتها بالشهور، إلا أن تكون طاعنة في السن بحيث يكون انقطاع حيضها لانتهائه عادة لا لاضطرابه فإنها لا تلغي ما تعتد به من الاطهار، بل تكمل عدتها بالشهور، فإذا اعتدت بطهر وحاضت حيضة واحدة ثم انقطع حيضها أتمت عدتها بشهرين، وإذا اعتدت بطهرين وحاضت حيضتين ثم انقطع حيضها أتمت عدتها بشهر، سواء بلغت سن اليأس أم ل.
هذ، إذا كانت حرة مطلقة أما إذا كانت متمتعاً بها أو أمة مطلقة فإنها إذا
اعتدت بطهر واحد وحاضت حيضة واحدة ثم انقطع حيضها بالنحو المذكور تلغي الطهر وتستأنف عدتها بشهر ونصف.
(مسألة ٧٥): عدة الحامل من الطلاق وضع الحمل وإن كان بعد الطلاق بلحظة.
(مسألة ٧٦): لا فرق في وضع الحمل بين كونه تاماً وكونه سقطاً إذا علم أنه مبدأ تكون آدمي.
(مسألة ٧٧): إذا كانت حاملاً بأكثر من واحد بانت من زوجها - إن كانت العدة رجعية - بوضع الاول، فلا يجوز لزوجها الرجوع بها حينئذٍ، لكن لا يحل لها الزواج حتى تضع ما بقي من حمله.
(مسألة ٧٨): الأحوط وجوباً في المتمتع بها إذا كانت حاملاً أن تعتد بأبعد الأجلين من وضع الحمل وعدتها إذا لم تكن حامل.
(مسألة ٧٩): الاعتداد بوضع الحمل يختص بما إذا كان الحمل محكوماً شرعاً بأنه من صاحب العدة، كالمطلِّق، أما إذا كان من غيره لشبهة أو زنا فلا دخل له في العدة، بل عدتها حينئذٍ الاطهار أو الشهور، على ما تقدم. هذا مع الدخول أما بدونه فلا عدة، كما تقدم.
(مسألة ٨٠): إذا توفي الزوج اعتدت زوجته أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كان الزواج دائماً أم منقطع، وسواء كان الزوجان كبيرين أم صغيرين، ومسلمين أم كافرين، وحرين أم مملوكين أم مختلفين في الكل.
هذا إذا لم تكن حامل، فإن كانت حاملاً فعدتها أبعد الأجلين من المدة المذكورة ووضع الحمل.
(مسألة ٨١): إذا طلقت المرأة ومات زوجها في العدة البائنة أتمت عدتها ولم تعتد للوفاة. أما إذا مات في العدة الرجعية فإن عليها أن تعتد عدة الوفاة.
هذا وربما زاد ما بقي من عدتها عن عدة الوفاة، كما لو كانت تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة فمات زوجها وهي في طهرها الاول، وحينئذٍ فالأحوط وجوباً أن تتمه بعد عدة الوفاة.
(مسألة ٨٢): إذا طلقت زوجة الغائب بعد الفحص عنه وجب عليها أن تعتد بقدر عدة الوفاة، كما تقدم في أول كتاب الطلاق.
(مسألة ٨٣): يجب على المرأة في عدة الوفاة الحداد بترك الطيب والزينة في البدن واللباس، ويجوز لها الغسل والتنظيف والتمشط وتقليم الاظفار ونحو ذلك مما لا يعد زينة عند العرف، بل حتى مثل الاكتحال إذا لم يكن للزينة، بل لحاجتها إليه أو لتعارفه من دون أن يعد زينة عرف.
(مسألة ٨٤): يجوز لها الاعتداد في بيت زوجها وفي أي بيت شاءت، بل لها أن تقضي عدتها في بيوت متعددة كل مدة في بيت. ويجوز لها الخروج من البيت الذي تعتد فيه، نعم هو مكروه إلا أن تكون في حاجة لذلك أو لاداء حق أو في طاعة، ولو تيسر لها أداء ذلك بالخروج بعد نصف الليل والرجوع في اليوم الثاني عشاءً كان أولى.
وأما ما شاع عند كثير من عوام الناس من أن عليها الاعتزال والاحتجاب حتى لا يرى شخصها من ليس محرماً لها ولا يسمع صوتها ولا يرى ما يحل كشفه من بدنه، وغير ذلك من القيود فليس له أصل شرعي.
(مسألة ٨٥): الحداد ليس شرطاً في العدة، بل هو واجب فيه، فعدم قيامها به جهلاً أو عمداً لا يبطل العدة، ولا يجب معه قضاؤه.
(مسألة ٨٦): لا يجب الحداد على الامة، ولا على الصغيرة والمجنونة، كما لا يجب على وليهما أو غيره إلزامهما به.
(مسألة ٨٧): لا يجب الحداد على المعتدة في غير عدة الوفاة، بل يستحب لذات العدة الرجعية أن تتجمل وتتزين لزوجه.
(مسألة ٨٨): تثبت عدة الطلاق في كل ما يوجب الفراق بعد الزواج الدائم، كفسخ النكاح بأحد العيوب المتقدمة، وبطلانه بعروض أحد أسباب البطلان كالرضاع المحرِّم. فإن كانت من ذوات الاقراء اعتدت بالاقراء، وإن كانت من ذوات الشهور اعتدت بالشهور، وإن كانت حاملاً اعتدت بوضع الحمل. وأما لو عرضت هذه الاُمور على الزواج المنقطع فعدتها عدة المتمتع بها المتقدمة.
(مسألة ٨٩): هذه العدة بائنة تخرج بها المرأة عن عصمة الزوج. ولا يجري عليها حكم العدة الرجعية.
(مسألة ٩٠): تثبت عدة الطلاق المتقدمة على المرأة الحرة بوطء الشبهة، سواء كانت الشبهة لتوهم وقوع العقد مع عدم وقوعه، كما لو اشتبهت على الرجل زوجته بغيرها فوطأه، أم لتوهم صحة العقد الباطل، كما لو تزوج ذات الزوج لتوهم خروجها عن عصمته، أو ذات العدة لتوهم عدم العدة، أو لتوهم عدم مانعية العدة من الزواج.
(مسألة ٩١): إذا كانت الموطوءة بالشبهة خليةً غير ذات زوج حرم عليها الزواج في عدته، وإن كانت مزوجة حرم على زوجها وطؤها في عدته، بل الأحوط وجوباً اعتزاله لها فلا يستمتع بها بقية الاستمتاعات، بل الأحوط وجوباً أيضاً عدم نظره إلى ما يحرم على غيره النظر إليه منه.
(مسألة ٩٢): المدار في وطء الشبهة على الشبهة من جانب الرجل، فمع الشبهة من طرفه تثبت العدة وإن كانت المرأة متعمدة الحرام، ومع عدم الشبهة من طرفه لا تثبت العدة وإن كانت المرأة في شبهة.
(مسألة ٩٣): لا عدة مع الزنا ولا استبراء، نعم يستحب استبراء المزني بها من ماء الفجور، بل هو الأحوط استحباب، خصوصاً إذا كان الزاني هو الذي يريد التزويج به.
(مسألة ٩٤): لا تعتد الموطوءة شبهة عدة الوفاة لموت الواطئ قبل ارتفاع الشبهة ولا لموته في العدة بعد ارتفاع الشبهة.
(مسألة ٩٥): إذا اجتمعت عدة وطء الشبهة مع عدة اُخرى للمرأة تتداخل العدتان، سواءً كانتا من سنخ واحد، كما لو وطأها رجل شبهة ووطأها آخر شبهة أيض، أو وطأها الواطئ نفسه في عدته، أم من سنخين، كما لو طلق الزوج المرأة بائناً ثم وطأها هو أو غيره شبهة، أو وطئت ذات الزوج من غيره شبهة فطلقها الزوج أو مات عنه، وغير ذلك. مثلاً لو وطأها رجل شبهة فشرعت في العدة ثم وطأها آخر بعد مضي شهر من العدة وجب عليها الاعتداد ثلاثة أشهر لوطء الثاني ولا يجب عليها إكمال عدة الاول ثم استئناف عدة الثاني.
(مسألة ٩٦): مبدأ عدَّة الطلاق والفسخ وبطلان عقد النكاح من حين حصول السبب، سواء بلغها الخبر حينه أم بعده، قبل مضي مقدار العدة أو بعده، فإذا بلغها بعد مضي زمان العدة فلا عدة عليه. نعم لو جهلت تاريخ حصول السبب بنت على تأخره.
(مسألة ٩٧): مبدأ عدة الوفاة على المرأة من حين يبلغها خبروفاة زوجه، لا من حين نفس الوفاة، من غير فرق بين الغائب والحاضر، حتى لو كانت المدة بين الوفاة وحصول الخبر قريبة كثلاثة أيام أو أربعة على الأحوط وجوب. كما أن الأحوط وجوباً العموم لمن لا يجب عليها الحداد كالامة والصغيرة.
(مسألة ٩٨): المراد ببلوغ الخبر وصول ذلك إليها بعلم أو حجة معتبرة يعمل عليه.
(مسألة ٩٩): مبدأ عدة وطء الشبهة من حين ارتفاع الشبهة وظهور الحال، لا من حين آخر وطء. ولو توفي الواطئ والشبهة باقية كان مبدأ
الوفاة، لكن العدة حينئذٍ عدة الطلاق لا عدة الوفاة كما سبق.
(مسألة ١٠٠): جميع أنواع العدة المتقدمة بائنة، إلا عدة الطلاق الرجعي وقد تقدم بيانه في أول الفصل الثاني.
(مسألة ١٠١): الطلاق البائن تخرج به المرأة عن عصمة الزوج وتصير أجنبية فليس له النظر إليه، ولا يجب عليه نفقتها ولا إسكانه، ولها الخروج من بيتها بغير إذنه، ولا تجب عليها طاعته، وله أن يتزوج الخامسة لو كانت هي الرابعة وغير ذلك. نعم ترثه إلى سنة إذا طلقها وهو مريض، على تفصيل تقدم في آخر كتاب الطلاق.
كما أن الأحوط وجوباً عدم تزوج إحدى الاُختين في عدة اُختها من النكاح المنقطع وإن كانت بائنة، واعتزال الزوجة بوطء اُختها أو اُمها شبهة حتى تنقضي عدة الوطء من الشبهة.
(مسألة ١٠٢): تبقى المرأة في عصمة الزوج في العدة الرجعية وهي بمنزلة الزوجة، فليس له الزواج باُخته، ولا بالخامسة إذا كانت هي الرابعة، ويتوارثان إذا مات أحدهما في العدة، ويجوز له الدخول عليها بغير إذنه، كما يجوز لها إبداء زينتها له، بل هو مستحب - كما تقدم - ويجب عليها طاعته، وإجابته لمواقعتها لو طلب ذلك وتكون مواقعته لها رجوعاً بها كما تقدم، كما يجب عليه نفقتها وإسكانها معه، ولا يجوز له إخراجها من بيته وترك إسكانها معه مراغماً له، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، والأحوط وجوباً الاقتصار في الفاحشة المبينة على القبيح من القول والفعل مما يتعلق بالجنس. أما لو تراضيا بعدم إسكانه لها وسكناها منفصلة فلا بأس.
(مسألة ١٠٣): لو أسكنها معه لم يجز لها الخروج بغير إذنه، إلا لضرورة لا تستطيع معها استئذانه، أما مع إذنه فلا بأس بخروجه، كالزوجة.
(مسألة ١٠٤): إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً رجعياً ورجع بها ثم طلقهاطلاقاً خلعياً أو غير خلعي - قبل الدخول - وجب عليها استئناف عدة تامة، ولا يكون طلاقاً بلاعدة، كما لا يكفي إكمال العدة الاُولى التي انقطعت بالرجوع.
(مسألة ١٠٥): لا تعتـد المرأة من صاحب العدة، فله أن يتزوجها في عدتها البائنة - إذا لم تحرم عليه من جهة اُخرى - كعدة الطلاق الخلعي، وعدة العقد المنقطع، وعدة فسخ النكاح أو بطلانه بأحد موجبات البطلان، وعدة وطء الشبهة.
لكن لو تزوجها دواماً أو متعة ثم خرجت عن عصمته قبل الدخول - بالطلاق أو هبة المدة أو فسخ النكاح أو بطلانه - لم تحل لغيره حتى تستكمل عدتها الاُولى بعد احتساب مدة زواجها الثاني منه. مثلاً: إذا كانت المرأة ممن تعتد من الطلاق بثلاثة أشهر، فطلقها زوجها - بعد الدخول - طلاقاً خلعياً في أول شهر رجب ثم عقد عليها في أول شهر شعبان ثم طلقها في أول شهر رمضان قبل الدخول به، لم يحل لغيره أن يتزوجها إلا في شهر شوال بعد إكمال عدتها الاُولى التي بدأت بشهر رجب.
وإذا كانت المرأة ممن تعتد من العقد المنقطع بشهر ونصف فوهبها المدة - بعد الدخول - في أول شهر شوال، ثم عقد عليها في نصف شهر شوال متعة، ثم وهبها المدة من دون أن يدخل بها في آخر شهر شوال لم يحل لغيره أن يتزوجها إلا بعد خمسة عشر يوماً من شهر ذي القعدة.
وربما يتوهم سقوط عدة الفراق الاول بالزواج الثاني وعدم العدة بالفراق من الزواج الثاني لانه قبل الدخول، فتحل لكل أحد بمجرد الفراق، حتى قيل: إن المرأة الواحدة تدور على جماعة في ليلة واحدة، فيعقد عليها أحدهم ويدخل بها ثم يهبها المدة ويعقد عليها ثانياً ثم يهبها المدة قبل الدخول فيعقد عليها الثاني ويدخل به، ثم يهبها المدة ويعقد عليها ثانياً ثم يهبها المدة قبل الدخول، ويعقد
عليها الثالث، وهكذا حتى تدور على الجماعة كلهم.
وإن صح ذلك فهو من الفجائع الفضيعة والمنكرات الشنيعة، وإن كان هناك من يفتي بجوازه كان شاهد عيان على نقصان الانسان، وأن غير المعصوم قد يتعرض للخطأ الفاضح والغفلة العجيبة ليكون ذلك عبرة تمنع من الاغراق في حسن الظن بغير المعصوم مهما بلغ شأنه، وداعياً للتثبت عند الفتوى وعدم التسرع فيها حذراً من سقطات الوهم وعثرات الفكر والنظر. ونسأله سبحانه وتعالى التسديد والتوفيق لتحقيق الحقائق، ونعوذ به من الخطل والزلل في القول والعمل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
الفصل الخامس
في الخلع والمباراة
وهما نوعان من الطلاق يبتنيان على طلب الزوجة من الزوج أن يفارقها مع بذلها له مالاً من أجل ذلك، فيكون فراقه لها إجابة لطلبها ورضىً بعرضه.
(مسألة ١٠٦): لما كان الخلع والمباراة من أنواع الطلاق فلابد فيهما من الشروط المتقدمة في الطلاق نفسه، كالاشهاد، وفي المطلق، كالبلوغ والعقل والقصد وعدم الاكراه، وفي المطلقة، ككونها في طهر لم يواقعها فيه، إلا ما استثني كالحامل والصغيرة وغيرهم، على التفصيل المتقدم في الطلاق.
(مسألة ١٠٧): يشترط في الخلع أن تكون المرأة كارهة لعلقة الزوجية بينها وبين الرجل، بنحو يؤدي ذلك إلى امتناعها عن القيام بحقوقه والتعدي عليه وعصيان الله تعالى فيه وأنتهاك حدوده، أو بحيث تهدد الزوج بذلك جادة به. ولا يكفي كراهتها للعلقة المذكورة إذا كانت ملتزمة بأداء حقوق الزوج تديناً أو تجمل، بل حتى لو احتمل أداء الكراهة للتفريط بحقوقه من دون أن
تهدد بذلك جادة به. بل لا يشرع الخلع لو لقنها غيرها وحملها على أن تهدد بذلك من دون أن يحرز قناعتها به وعزمها على الجري عليه.
(مسألة ١٠٨): يشترط في المباراة كراهة كل من الزوجين للآخر وإن لم يبلغ حد التعدي من أحدهما على الآخر والتفريط بحقه.
(مسألة ١٠٩): لا يشرع الخلع والمباراة لتفادي مشاكل اُخرى على المرأة تابعة لعلقة الزوجية من دون كراهة له، بأن صعب عليها مثلاً أداء بعض حقوق الزوج أوالسفر معه أو معاشرة أهله، فضلاً عما إذا كان ذلك منها لامر خارج عن العلقة الزوجية، كاستجابة لطلب أهلها أو لعرف عشائري أو خوف من ظالم أو رغبة في خير موعود به، أو غير ذلك.
(مسألة ١١٠): يحرم على الزوج التعدي على زوجته والتضييق عليها من أجل أن تتخلص منه ببذل ماله، ففي ذلك استغلال لضعفه، وهو من أفحش الظلم، وفي الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «ومن أضرّ بامرأة حتى تفتدي نفسها منه لم يرض الله له بعقوبة دون النار، لأن الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم... ألا وإن الله ورسوله بريئان ممن أضرّ بامرأته حتى تختلع منه». وكذا الحال في غير الزوج ممن يتدخل بين الزوجين ويسعى لحمل الزوجة - بالترغيب والترهيب والمضايقات - على البذل وطلب الطلاق. ولو سولت النفس وغرَّ الشيطان الزوج أو غيره فأجرم وفعل ذلك فطلبت الطلاق وبذلت لم يحل للزوج ما بذلت ولم يقع الخلع ولا المباراة.
نعم إذا أدى ذلك إلى حصول شرط الخلع أو المباراة بالنحو المتقدم فبذلت حلّ المال وصح أحد الامرين، وتحمل المسبب لذلك إثم هذه الجريمة.
(مسألة ١١١): حيث تقدم ابتناء الخلع والمباراة على بذل المال من قبل الزوجة، فلابد من كون الشيء المبذول مما يصح التعاوض به شرع، عيناً كان
أو منفعة أو حق، دون مثل الخمر والخنزير. كما لابد من كونه معين، ولا يكفي المردد، كأحد الثوبين أو ما يطلبه الزوج. نعم لا بأس بجهالته مع تعيينه، كما لو بذلت مجموعة من الاوراق النقدية من دون أن يعرف قدره.
(مسألة ١١٢): لا حدّ في الفداء من حيثية القلة والكثرة. نعم لابد في المباراة من أن لا يتجاوز الفداء مقدار المهر، ولا بأس في الخلع بزيادته عن ذلك.
(مسألة ١١٣): لا بد من كون الفداء الذي تبذله المرأة مالاً لها تملكه قبل البذل أو تجعله عليها وفي ذمتها عند البذل. ولا يصح أن تبذل مال غيرها حتى لو كان بإذنه. نعم لو أذن لها في تملكه وبذله فتملكته وبذلته فلا إشكال.
(مسألة ١١٤): لابد من كون الطالب للفراق الباذل من أجله هو الزوجة، ولا يجزئ طلب غيرها - كأبيها وعشيرتها - حتى لو كانت كارهة بالوجه المتقدم وكان الفداء ملكاً لها وبذله بإذنه. نعم إذا كان الغير وكيلاً عنها في طلب الفراق وبذل الفداء أجزأ طلبه وبذله.
(مسألة ١١٥): لابد في الخلع والمباراة من أن يكونا مرتبطين بالبذل متفرعين عليه، نظير ارتباط القبول بالايجاب، فلا يكفي فيهما العلم برضا المرأة بالفداء من دون أن تبذله فعل، وكذا إخبارها للزوج بأنها مستعدة للبذل في سبيل فراقه، بل لا يصح به الخلع ولا المباراة ما لم يتحقق منها البذل بالفعل فيخلعها أو يباريها استجابة له.
(مسألة ١١٦): يشرع الإتيان بصيغة الخلع والمباراة بأحد وجهين..
الأول: أن يأتي بصيغة الطلاق، فيقول: أنت طالق على ما بذلت، أو فلانة طالق على ما بذلت.
الثاني: أن ينشئ الفراق خالياً عن صيغة الطلاق، ويجزئ فيه كل ما يدل على إخراجها عن زوجيته وحبالته وعصمته من غير أن يتضمن فسخ عقد
النكاح وحله.
فيقول في الخلع: خلعتك على كذ، أو أنت مختلعة على كذ، أو خلعت فلانة على كذ، أو هي مختلعة على كذ، ويقول في المباراة: بارأت فلانة على كذ، أو بارأتك على كذ. أويقول فيهما معاً: فارقتك على كذا أو فارقت فلانة على كذا أو تركتك على كذا أو تركت فلانة على كذ. بل لو قالت في مقام البذل: اخلعني على كذ، أو: بارئني على كذ، أو: لك كذا واخلعني، أو بارئني، أوفارقني، فقال قاصداً إنشاء الخلع أو المباراة: رضيت بذلك، بحيث تحقق منهما معاً الرضا بذلك كفى في تحقق أحد الامرين، بلا حاجة حينئذٍ إلى إنشاء الفراق من الزوج ابتداءً.
ولا يحتاج في الوجه الثاني إلى الإتيان بعد ذلك بصيغة الطلاق. نعم هو أحوط استحباباً خصوصاً في المباراة، فيقول - بعد تمامية الخلع أو المباراة بإحدى العبارات المتقدمة في الوجه الثاني ومع بقاء شروط الطلاق - كحضور الشاهدين وطهر المرأة ـ: فلانة طالق، أو:أنت طالق.
(مسألة ١١٧): لابد في الخلع والمباراة من التنجيز، فلا يصحان معلقين على أمر مستقبل أو حاضر مجهول الحصول. نعم لا بأس بتعليقهما على أمر حاضر معلوم الحصول، كما لا بأس بتعليقهما على ما يتوقف صحتهما عليه، كما لو قال: خلعتك أو بارأتك إن كنت كارهة لي، أو إن كنت زوجتي. وبذلك يفترقان عن الطلاق، حيث تقدم عدم صحة تعليقه حتى على ما يتوقف صحته عليه.
(مسألة ١١٨): لا تشترط المباشرة في الخلع والمباراة، بل يمكن لكل من الطرفين التوكيل في طلب الفراق والبذل، وفي إيقاع الفراق استجابة للطلب ومبتنياً على البذل.
(مسألة ١١٩): إذا خلعها أو بارأها على ما لا يصح التعاوض به شرع
ـ كالخمر والخنزير - لم يصح الخلع ولا المباراة، كمالا يقع طلاقاً بلا عوض، بل تبقى المرأة زوجة. من دون فرق بين إقدامهما على ذلك عمداً وعدمه، بأن وقع ذلك منهما خطأ جهلاً بالحكم أو الموضوع. وكذا الحال إذا لم تكن الفدية ملكاً للمرأة، بل مملوكة لغيرها أو وقف. نعم لو كان قد أتبعها بالطلاق المجرد - كما تقدم أنه مقتضى الاحتياط في الوجه الثاني - صح الطلاق وكان رجعياً أو بائناً حسب اختلاف الموارد.
(مسألة ١٢٠): إذا ظهر بعد الخلع أو المباراة أن الفدية معيبة أو على خلاف ما وصفت لم يبطل الخلع ولا المباراة. وفي استحقاق الرجل الارش أو التبديل إشكال، فاللازم الاحتياط. هذا إذا كانت الفدية شيئاً معيناً في الخارج كثوب خاص، أما إذا كانت أمراً كلياً في ذمة المرأة كعشرة مثاقيل من الذهب، فسلمت للرجل فرداً معيباً أو مخالفاً للوصف فلا إشكال في استحقاق الرجل التبديل، وإن تعذر على المرأة التبديل كان عليها إرضاء الرجل ولو بالمصالحة معه على شيء من المال.
(مسألة ١٢١): تعتدّ المرأة من الخلع والمباراة عدة الطلاق إذا كانت ممن تعتدّ في الطلاق، كالمدخول بها وهي في سن الحيض، إلا أن عدتها بائنة، حتى لو كانت المرأة بحيث لو طلقت من دون خلع ولا مباراة لكان طلاقها رجعي، فتجري عليها أحكام العدة البائنة، كعدم جواز الرجوع للرجل فيه، وعدم التوارث بينهما لو مات أحدهما في أثنائه، وغير ذلك.
(مسألة ١٢٢): للمرأة الرجوع في الفدية ما دامت في العدة بشرطين..
الأول: بقاء الفدية في ملك الزوج، فلو خرجت عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف فلا مجال لرجوعها به. هذا إذا كانت عيناً خارجية كثوب خاص. أما إذا كانت أمراً كلياً فسلمته فرداً منه فخرج عن ملكه ففي صحة رجوعها به مع
تكليف الرجل أن يدفع إليها فرداً آخر إشكال، فلا يترك الاحتياط.
الثاني: أن يشرع للرجل الرجوع بالمرأة. ولابد في ذلك من أمرين..
أحدهما: كون المرأة لو طلقت من دون خلع ولا مباراة لكان طلاقها رجعي.
ثانيهما: عدم حصول ما يمنع من الرجوع فيه، كما لو تزوج اُخته، أو صار له أربع زوجات دائمة غيره، أو أرضعت هي زوجته فصارت اُمها بالرضاع، أو نحو ذلك.
هذ، ويشترط في الخلع شرط ثالث، وهو أن تقلع عن التعدي على حقه وتتوب من معصية الله تعالى فيه.
(مسألة ١٢٣): إذا كانت المرأة قد تزوجت من دون ذكر مهر فاختلعت قبل الدخول لم يكن لها متعة، بخلاف ما لو طلقت بلا عوض، فإنها تمتع كما سبق في المهور.
(مسألة ١٢٤): الخلع والمباراة وإن لم يجبا على الزوج عند بذل المرأة، إلا أنه إذا توقف حل المشكلة على أحدهما فلا ينبغي له التعنت والتصلب إحراجاً للمرأة أو تشفياً منه، فإن الله تعالى إنما شرعهما لحل المشاكل المستعصية حذراً من انتهاك حرماته وتعدي حدوده، وليتسنى لكل من الزوجين أن يعيش تجربة اُخرى قد يحصل بها على البيت السعيد والعيش الرغيد. قال جلت آلاؤه وعظمت نعماؤه: (وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته وكان الله واسعاً حكيم)ولم يجعل الله تعالى الامر للرجل من أجل أن يتعنت ويستغل موقعه، إجحافاً بالمرأة واستهواناً به، بل لانه الارشد والاقدر على ملاحظة مقتضيات الحكمة والعمل عليه. فينبغي له أن يؤدي شكر نعمة الله تعالى عليه في ذلك بأن يقوم بمقتضى مسؤوليته ويخرج عن عهدته.
(مسألة ١٢٥): إذا لم تتم شروط الخلع والمباراة لم يشرع الطلاق بالعوض
المبذول من المرأة أو غيره، وانحصر الامر بالطلاق المجرد عن العوض. نعم يمكن بذل العوض للزوج من المرأة أو غيرها وتمليكه له بشرط الطلاق، فإذا قبل الزوج بذلك وجب عليه الطلاق وفاء بالشرط، فلو لم يطلق كان عاصي، وكان للباذل الرجوع في البذل. وإن طلق جرى عليه حكم الطلاق بلا عوض، الذي قد يكون رجعي، كما لو كانت المرأة مدخولاً بها وفي سن من تحيض وكان هو الطلاق الاول أو الثاني. وحينئذٍ يكون للزوج الرجوع، إلا أن يشترط عليه عند البذل والتمليك عدم الرجوع حينئذٍ، فيلزمه الشرط ويحرم عليه الرجوع. لكن لو عصى ورجع ففي نفوذ رجوعه إشكال، واللازم الاحتياط.
نعم لا ينبغي سلوك هذا الطريق، إلا عند ضرورة تسوغ تقويض بيت الزوجية من دون أن يلزم حيف على المرأة، وإلا تحمل من يقوم بذلك مسؤولية جسيمة وإن كانت المعاملة صحيحة والشرط نافذ.
ومنه سبحانه نستمد التوفيق والتسديد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
الفصل السادس
في الظهار
وهو تشبيه من يحل نكاحها بالفعل - من زوجة أو أمة - بإحدى المحارم بقصد تحريمها عليه، على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.
وهو من مبتدعات الجاهلية، وقد استنكره الله تعالى لما فيه من تحريم ما أحلّ، قال عز من قائل: (الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن اُمهاتهم إن اُمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزور). وقد عاقب الله تعالى من أقدم عليه بإلزامه بما قال وتحريم من حرّمها على نفسه حتى يكفّر. فحريٌّ بالمؤمن أن يتجنب ذلك ويتثبت في أفعاله وأقواله، ويحفظ لسانه عن
الخطل والباطل مهما كانت الظروف المحيطة به، مراعياً تعاليم الله تعالى ومتأدباً بأدبه، ولئلا يحرج نفسه ويضيق عليها وعلى أهله متكلفاً بذلك ومتعدي.
(مسألة ١٢٦): المُظاهِر هو الرجل، ولا يقع الظهار من المرأة لتحريم الرجل عليه.
(مسألة ١٢٧): يتحقق الظهار بأن يقول الرجل للمرأة بقصد تحريمها عليه: أنت عليّ كظهر اُمي. ويكفي كل ما يدل على المرأة التي يراد تحريمه، كفلانة، أو هي. كما يكفي كل ما يدل على التشبيه، مثل: أنت عليّ ظهر اُمي، أو: أنت مني كظهر اُمي، أو: أنت حرام عليّ كظهر اُمي، إلى غير ذلك.
(مسألة ١٢٨): يقوم مقام الاُم جميع المحرمات النسبية، كالاُخت وبنتها وبنت الاخ والعمة والخالة، بل مطلق المحرمات بالنسب والرضاع والمصاهرة.
(مسألة ١٢٩): الظاهر اختصاص الظهار بما إذا اُخذ في المشبَّه به العنوان المحرم، كالاُم والاُخت، دون شخص المرأة التي هي محرم، فإذا قال: أنت عليّ كظهر زينب، وكانت زينب اُمه أو اُخته لم يقع الظهار.
(مسألة ١٣٠): يقوم مقام الظهر كل عضو من أعضاء المحارم، كالرجل واليد والبطن والفرج وغيره. وكذا لو كان المشبَّه به هو المرأة المحرم نفسه، كما لو قال: أنت علي كاُمي أو كاُختي.
(مسألة ١٣١): لا يقع الظهار بالتحريم المجرد عن التشبيه بالمحارم، كما لو اقتصر على قوله: أنت عليّ حرام.
(مسألة ١٣٢): لا يقع الظهار موقتاً بزمان، كشهر أو سنة، بل لابد فيه من الاطلاق وعدم التوقيت.
(مسألة ١٣٣): لا يقع الظهار مؤجل، كما لو قال: أنت عليّ كظهر اُمي
من يوم الجمعة، أو عند خروج هذا الشهر.
(مسألة ١٣٤): لا يقع الظهار في يمين، وهو الذي يراد به الحمل على فعل أو الزجر عنه، كما لو قال: أنت عليّ كظهر اُمي إن تركت صلاة الليل، أو إن اغتبت مؤمن. وفي وقوعه مشروطاً بشيء من دون أن يراد به اليمين على تركه إشكال، والاظهر العدم.
(مسألة ١٣٥): يشترط في المظاهر البلوغ والعقل والقصد إلى الظهار المعهود المبني على تحريم المرأة مع بقائها على الزوجية، فلو قصد به الكناية عن الطلاق لم يقع ظهاراً ولا طلاق.
(مسألة ١٣٦): يشترط في المظاهر الاختيار، فلا يقع الظهار مع الاكراه، ولو لأجل إرضاء الغير، كاُمه وزوجته تجنباً لبعض المشاكل.
(مسألة ١٣٧): لا يقع الظهار مع الغضب والانفعال تسرعاً من دون قصد سابق.
(مسألة ١٣٨): يقع الظهار بالزوجة دائمة كانت أو متمتعاً به، ولا يقع بالاجنبية، حتى لو علقه على الزواج به، بأن قال مثلاً: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر اُمي.
(مسألة ١٣٩): لا يقع الظهار بالمرأة إلا بعد الدخول بها ولو دبر.
(مسألة ١٤٠): لابد في الظهار من أن تكون المرأة في طهر لم يواقعها فيه إذا كانت في سن الحيض، على التفصيل المتقدم في الطلاق. وفي جريان حكم الغائب هنا إشكال، فاللازم الاحتياط.
(مسألة ١٤١): لابد في الظهار من شهادة عادلين، على النحو المتقدم في الطلاق.
(مسألة ١٤٢): لا يقع الظهار في إضرار. والظاهر أن المراد بذلك ما إذا أوقعه بقصد الاضرار بالمرأة والايذاء له.
(مسألة ١٤٣): إذا تمّ الظهار حرم على المُظاهِر وطء المرأة المظاهَرة ما دامت زوجة له حتى يكفّر، ولا يحرم عليه غير الوطء من وجوه الاستمتاع، فإن كفّر حلّ الوطء، وإن وطأها قبل أن يكفر عصى ووجبت عليه كفارة اُخرى للوطء المذكور، وهكذا إذا كرر الوطء قبل التكفير اللازم بالظهار، فإن الكفارة تتعدد بتعدد الوطء.
(مسألة ١٤٤): إذا خرجت المرأة المُظاهَرة عن زوجية المُظاهِر بطلاق أو غيره سقط الظهار وسقطت معه الكفارة، فإن عادت له بتزويج جديد حلّ له وطؤها بلا كفارة. نعم لو طلقها طلاقاً رجعياً ورجع بها قبل خروجها عن العدة لم يسقط الظهار فلا يحل له وطؤها حتى يكفر، كما لو لم يطلقه.
(مسألة ١٤٥): إذا تعدد الظهار على المرأة الواحدة في مجلس واحد أجزأته كفارة واحدة في تحليل وطئه، أما مع تعدد المجلس فاللازم تعدد الكفارة بتعدد الظهار المتفرق. نعم لو وطأها قبل التكفير لزمته كفارة واحدة للوطء مهما تعدد الظهار.
(مسألة ١٤٦): إذا ظاهر من نساء متعددات كان لكل امرأة ظهاره، حتى لو كان ظهارهن جميعاً بكلام واحد، وحينئذٍ يحرم عليه وطء كل واحدة حتى يكفر له، ولا يجزئه كفارة واحدة لتحليلهن جميع.
(مسألة ١٤٧): كفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكين. لكل مسكين مد، هذا في الحر، وأما العبد فكفارته صيام شهر واحد.
(مسألة ١٤٨): المراد بالتتابع هنا هو المراد بالتتابع في سائر الكفارات،
وهو أن يصوم شهراً تاماً ويوماً من الشهر الثاني، ثم له أن يفرق الصوم حتى يكمل الشهر الثاني. وقد تقدم في أواخر كتاب الصوم بعض فروع التتابع.
(مسألة ١٤٩): إذا لم يقدر على العتق وشرع في الصيام ثم وطأ المرأة المظاهَرة قبل إكمال الصوم لزمه كفارة الوطء قبل التكفير. ثم إن أخل الوطء بالتتابع - كما لو وطأها نهاراً قبل مضي شهر ويوم - وجب عليه استئناف صوم كفارة الظهار، وإن لم يخل به - كما لو وطأها ليلاً أو بعد مضي شهر ويوم - أجزأه إكمال صوم كفارة الظهار الذي شرع فيه ولم يجب استئنافه.
(مسألة ١٥٠): إذا عجز عن عتق الرقبة فشرع في الصوم ثم أيسر، فإن كان قد دخل في الشهر الثاني أجزأه إتمام الصوم، وإلا وجب عليه العتق. أما إذا عجز عن العتق والصوم فشرع في الاطعام ثم قدر على أحدهما قبل إكماله فإن الأحوط وجوباً التكفير بالعتق أوالصيام وعدم الاجتزاء بما أتى به من الاطعام إلا أن يستمر العجز حتى يكمله.
(مسألة ١٥١): إذا عجز عن الخصال المتقدمة وآخرها إطعام ستين مسكيناً صام ثمانية عشر يوماً عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام. ولا يجب فيها التتابع، وإن كان أحوط استحباب.
(مسألة ١٥٢): إذا عجز حتى عن صوم الثمانية عشر يوماً ففي الاجتزاء بالاستغفار في تحليل الوطء - مع بقاء الكفارة في ذمته حتى يقدر عليها - إشكال، والأحوط بل الأظهر العدم، ويجري عليه حينئذٍ ما يأتي في المسألة الاتية.
(مسألة ١٥٣): إن كفّر المُظاهِر فلا إشكال، وإن لم يكفر فإن صبرت المرأة المظاهَر منها فذاك، وإلا انتُظِر بالرجل ثلاثة أشهر من حين الظهار ثم كان لها أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي، فيلزمه بأحد الامرين من الكفارة أو الطلاق، ومع إبائه عن ذلك فإن أمكنه التضييق عليه حتى يطلق بنفسه فالأحوط وجوباً
ذلك، وإلا طلق عنه، وكان الطلاق بائناً أو رجعياً حسب اختلاف الموارد، فإن كان رجعياً كان له الرجوع في العدة، ووجب عليه التكفير، وإلا اُلزم مرة اُخرى بالطلاق، حتى ينتهي به إلى التكفير والوطء أو خروجها عن عصمته وبينونتها منه.
الفصل السابع
في الإيلاء
وهو الحلف على ترك وطء الزوجة على وجه مخصوص يأتي الكلام فيه، فإن خرج عن ذلك كان يمين، ولحقه حكم اليمين المحض في اللزوم وعدمه، على ما يأتي تفصيله في بحث اليمين إن شاء الله تعالى.
ولا ريب في كراهته من وجوه..
الأول: ما يأتي من كراهة اليمين إعظاماً لاسم لله تعالى أن يحلف به.
الثاني: ما يأتي أيضاً من كراهة أن يتعرض الانسان للحقوق ويجعلها على نفسه بنذر ونحوه.
الثالث: أنه يبتني على الاضرار بالمرأة والايذاء له. فينبغي للمؤمن تجنب ذلك والتحلي بالحلم والصبر وضبط النفس، ولا يندفع في مواقفه الانفعالية إلى ما قد يحرج نفسه ويؤذي أهله بما هو في غنىً عنه، وليبق لنفسه حرية الاختيار، التي جعلها الله تعالى له ولا يفرط به. والله سبحانه وتعالى وليّ التوفيق والتسديد.
(مسألة ١٥٤): لا يقع الايلاء إلا بالحلف بالله تعالى، كما هو الحال في سائر الايمان، على ما يأتي في بحث اليمين إن شاء الله تعالى.
(مسألة ١٥٥): لابد في الايلاء من أن يكون الحلف على ترك وطء الزوجة
بقصد الاضرار بها وإغضابها وهجره. فلو كان بداعي أمر آخر - من مرض أو مراعاة الولد أو غيرهما - لم يكن إيلاء، وجرى عليه حكم اليمين المحض.
(مسألة ١٥٦): الظاهر وقوع الايلاء معلقاً على شرط، كما لو قال: والله لا اُجامعك إن خرجت من الدار، أو إن طلعت الشمس.
(مسألة ١٥٧): يقع الايلاء مؤبد، كما لو قال: والله لا اُجامعك أبداً أو دائم. ويقع أيضاً مطلق، كما لو قال: والله لا اُجامعك، فيكون بحكم المؤبد. ويقع أيضاً مؤقت، كما لو قال: والله لا اُجامعك إلى سنة. نعم لابد حينئذٍ من أن يكون الامد أكثر من أربعة أشهر، وإلا لم ينعقد الايلاء، ولحقه حكم اليمين المحض.
(مسألة ١٥٨): لابد في الرجل المولي من أن يكون بالغاً عاقلاً قاصداً مختار، على نحو ما تقدم في الظهار، وأن يكون قادراً على جماع المرأة التي يؤلي منه، فلا يقع من المجبوب والعنين، ولا مع كون المرأة رتقاء أو نحوها ممن يتعذر وطؤه.
(مسألة ١٥٩): لابد في المرأة المؤلى منها من أن تكون زوجة دائمة مدخولاً به، ولا يقع الايلاء بدون شيء من ذلك، بل يكون يميناً محض.
(مسألة ١٦٠): إذا تمّ الايلاء وانعقد فلابد من الكفارة عند وطء الزوجة حتى لو كان الوطء المحلوف على تركه راجح. وبذلك يختلف الايلاء عن اليمين المحض، فإن اليمين لا ينعقد إذا كانت مخالفته راجحة - كما يأتي - ولا تجب بمخالفته الكفارة.
(مسألة ١٦١): كفارة الايلاء هي كفارة اليمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام، على ما يأتي في بحث اليمين إن شاء الله تعالى.
(مسألة ١٦٢): المشهور أن الكفارة في الايلاء تجب بعد الوطء كما في اليمين، لكن الظاهر أنها شرط في جواز الوطء، فلابد من تقديمها عليه ككفارة
الظهار. نعم لو وطأ قبل التكفير لم تجب كفارة اُخرى، بل يجزأ بكفارة واحدة للوطء اللاحق، ويكفي الاستغفار للوطء الاول، على خلاف ما تقدم في الظهار.
(مسألة ١٦٣): إذا آلى الرجل من امرأته، فإن صبرت فذاك، مهما طالت المدة، ولها أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي من يوم آلى منها أو بعد ذلك، فيمهله الحاكم أربعة أشهر من حين رفع أمرها له يخيره فيها بين أن يفيء ويرجع - وذلك بأن يدفع الكفارة ويجامعها - وأن يطلق، فإذا مضت الاربعة أشهر ولم يفعل أحد الامرين أجبره على أحدهم، بأن يحبسه ويضيق عليه في المطعم والمشرب ونحو ذلك حتى يفعل أحدهم، فإن لم ينفع ذلك وأيس منه طلق الحاكم عنه وفرق بينهم.
(مسألة ١٦٤): لو حصل الطلاق كان بائناً أو رجعياً حسب اختلاف الموارد. فإن كان رجعياً ورجع اُلزم بأحد الامرين أيضاً على النهج السابق.
(مسألة ١٦٥): إذا طلقها وبانت منه ثم تزوجها لم يسقط حكم الايلاء ووجبت الكفارة بالوطء.
(مسألة ١٦٦): لا تتعدد الكفارة بتعدد الحلف مع اتحاد الزمان الذي وقع الحلف على ترك الوطء فيه، بل تجب كفارة واحدة.
الفصل الثامن
في اللعان
أكد الاسلام فيما أكد على تهذيب اللسان وعفته، وقد ورد الردع عن قذف غير المسلم بالفاحشة ما لم يطلع على ذلك منه، فعن الامام الصادق (عليه السلام) أنه نهى عن قذف من ليس على الاسلام إلا أن يطّلع على ذلك منهم. وقال: «أيسر ما يكون أن يكون قد كذب».
أما المسلم فقد أكد على عرضه وشدد فيه حتى قال تعالى: (إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم* يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون * يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين). وقد عدّ قذف المحصنة من الكبائر، بل من أكبر الكبائر، ومن الكبائر السبع الموجبات. ثم لم يكتف بذلك حتى جعل عليه حداً أو تعزيراً - على تفصيل مذكور في محله - يكونان عقوبة معجلة في الدنيا رادعة لمن لم يرتدع بعذاب الآخرة الموعود.
ولا يسقط ذلك إلا شهود أربعة يشهدون بالفاحشة عن حسّ ومعاينة لا عن حدس وتخمين، وبدون ذلك يعدّ القاذف عند الله تعالى كاذباً فاسقاً منتهكاً لحرماته مستحقاً للحد، ولا تقبل شهادته، بل يلزم على المؤمنين ردعه وتكذيبه وإن احتملوا صدقه أو ظنوا به.
ومع الاسف الشديد نرى تهاون الناس في ذلك، وتسرعهم في الطعن والقذف لاوهام وظنون واتهامات لا تغني من الحق شيئ، ولا تنهض حجة بين يدي الله تعالى، غافلين أو متهاونين بتعاليم الله تعالى، قال عز من قائل
حديث الافك بعد أن شدد في الانكار على من قام به: (لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين * لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فاُولئك عند الله هم الكاذبون * ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسَّكم في ما أفضتم فيه عذاب عظيم * إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيّناً وهو عند الله عظيم * ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم * يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين).
فعلى المؤمنين أن يتأدبوا بأدب الله تعالى، ويتورعوا عن محارمه، ويقفوا عند حدوده التي لم يجعلها إلا لصلاحهم وخيرهم.
وقد استثنى الله تعالى من ذلك الزوج مع زوجته لأن قيامها بالفاحشة خيانة عظيمة له، وقد توجب إلحاق ولد غيره به، وكثيراً ما لا يتيسر له إقامة الشهود، فاكتفى منه عند رمي زوجته باللعان بشروط مشددة، وتكون نتيجته الحرمة المؤبدة بينهما والفراق الدائم. من دون أن يسوغ لغيره التعويل عليه في رمي المرأة وقذفها وانتهاك حرمته، فإذا لاعن الرجل زوجته وفارقها حرم على غيره قذفها بالزنى.
وقد عقدنا هذا الفصل للنظر في شروط اللعان وكيفيته وأحكامه.
(مسألة ١٦٧): إنما يشرع اللعان بقذف الزوج زوجته إذا لم يشهد بزناها أربعة شهود مقبولي الشهادة يثبت زناها شرعاً بشهادتهم، أما مع ذلك فلا لعان، بل تكفي شهادتهم في ثبوت الحد عليها وسقوط حد القذف عن الزوج. ولابد من إقامتهم الشهادة، أما بدون ذلك فيشرع اللعان حتى لو كانوا مستعدين لاقامة الشهادة لو دعوا إليه.
(مسألة ١٦٨): يكفي في الشهود الاربعة أن يكون أحدهم الزوج، ول
يجب أن يكونوا غيره.
(مسألة ١٦٩): إنما يشرع اللعان بقذف الزوجة إذا ادعى الزوج أنه عاينها تزني، أما إذا لم يدّع المعاينة فإنه يجري عليه حكم القاذف.
(مسألة ١٧٠): تقدم في أحكام الاولاد الضابط في إلحاق الولد بالرجل ظاهر، وأنه لا يحل للرجل نفي الولد عنه، بل لا يقبل منه النفي مع اعترافه بتحقق الضابط المذكور. أما مع عدم اعترافه بتحققه فيقبل منه نفي الولد عنه مع كون المرأة موطوءة بالملك أو متمتعاً بها أو زوجة دائمة لم يدخل به. أما إذا كانت زوجة دائمة مدخولاً بها فلا يقبل من الزوج نفي الولد إلا باللعان، أو بإقامة البينة على ما يمنع من تولد الولد منه.
وحينئذٍ نقول: إن رجع نفي الولد إلى قذف اُمه بالزنى توقف انتفاء الولد وسقوط حد القذف عن الزوج على اللعان، لكن لا يشترط حينئذٍ أن يدعي معاينة الزنى منه، بل يكفي فيه أن يدعي عليها أنها حملت به من الزنى.
وإن لم يرجع إلى قذف الاُم بالزنى - لاحتمال وطئها من قبل الغير شبهة أو مكرهة، أو إدخال مني الاجنبي في فرجها من دون أن يطأها - انحصر نفي الولد بإقامة البينة على ما يمنع من تولد الولد منه، فإن لم يتيسر له ذلك تعين لحوق الولد به ظاهراً وإلزامه به، نعم له وعليه فيما بينه وبين الله تعالى أن لا يجري عليه أحكام ولده لو علم بعدم تولده منه، كما لو علم من نفسه أنه كان عقيماً أو أنه لم يطأ المرأة وطءً يقتضي إلحاق الولد به أو غير ذلك.
(مسألة ١٧١): قذف الزوجة بالزنى بمجرده لا يقتضي نفي الولد، سواءً أشهد على زناها أم أقرت به أم تلاعن، بل يلحق الولد به لانه صاحب الفراش، ويتوقف انتفاء الولد منه على أن يدعي أنها حملت بالولد من الزنى، ويلاعنها على ذلك.
(مسألة ١٧٢): يشترط في المتلاعنين البلوغ، والعقل، وأن يكونا زوجين زواجاً دائماً مع الدخول، كما يشترط في الزوجة الملاعَنة أن لا تكون خرساء أو نحوها ممن لا تستطيع الكلام، وقد تقدم في السبب الرابع من أسباب تحريم النكاح أن قذف الخرساء ونحوها موجب لتحريمها وإن لم تلاعن.
(مسألة ١٧٣): صورة اللعان أن يشهد الزوج القاذف أربع شهادات بالله تعالى أنه صادق فيما رماها به، فيقول مثلاً: أشهد بالله أني صادق فيما رميتها به، ثم في الخامسة يجعل لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فيقول مثلاً: لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به، ثم تشهد الزوجة المقذوفة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، فتقول مثلاً: أشهد بالله أنه كاذب فيما رماني به، ثم في الخامسة تجعل غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فتقول مثلاً: غضب الله عليّ إن كان صادقاً فيما رماني به.
(مسألة ١٧٤): يجب التلفظ بالشهادات من الزوج، إلا في الأخرس ونحوه ممن يتعذر في حقه النطق، فإنه تكفيه الإشارة المفهمة صريحاً حسب ما يعلم من حاله. أما الزوجة فلا يشرع اللعان معها إذا كانت خرساء كما تقدم.
(مسألة ١٧٥): يجب النطق بالشهادات بالعربية مع الامكان، ومع تعذرها يجزئ غيره.
(مسألة ١٧٦): يجب القيام عند الشهادة، بل الأحوط وجوباً قيامهما معاً في تمام الملاعنة، فتقوم المرأة مع الرجل عند بدئه بالشهادة، ويبقى الرجل قائماً معها حتى تكمل هي الشهادة.
(مسألة ١٧٧): يستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة، ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة - والصبي المنفي إن كان - عن يساره مستقبلين القبلة. كما يستحب أن يعظ الحاكم كلاً منهما بعد أن يشهد الشهادات الاربع قبل الخامسة، ففي الصحيح - بعد ذكر الشهادات الاربع من الرجل ـ: «ثم قال رسول
الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أمسك، ووعظه، ثم قال: اتق الله فإن لعنة الله شديدة»، وبعد ذكر الشهادات الاربع للمرأة: «ثم قال لها:أمسكي، فوعظها ثم قال لها: اتقي الله فإن غضب الله شديد». قيل: ويستحب حضور جماعة من الاعيان والصلحاء يسمعون اللعان، لكن لو تم ذلك فقد ورد الامر بالتباعد عن المتلاعنين، وحينئذٍ يحضرون بنحو يسمعون التلاعن مع بعدهم عن مجلس الملاعنة.
(مسألة ١٧٨): إذا قذف الرجل المرأة ولم يكن له شهود عرض عليه الحاكم اللعان، فإن أبى حدَّه حدَّ القاذف، وكذا إذا أكذب نفسه. وإن لاعن وأتى بالشهادات الخمس سقط عنه الحد، ثم يعرض الحاكم على المرأة اللعان، فإن أبت أو صدقته ثبت عليها حد الزنى، وإن لاعنت وأتت بالشهادات الخمس سقط عنها الحد، وحرمت عليه مؤبد، كما تقدم في فصل أسباب تحريم النكاح.
(مسألة ١٧٩): إذا لاعن لنفي الولد وتم اللعان انتفى الولد منه واُلحق باُمه، ولا يحكم عليه أنه ابن زنى، بل من نسبه لذلك لزمه حد القذف، وحينئذٍ لا يرث الولد من الملاعِن ولا ممن يتقرب به، ولا يرثونه، بل يكون التوارث بينه وبين اُمه ومن يتقرب بها لا غير.
(مسألة ١٨٠): مع اختلال شروط اللعان المتقدمة وعدم مشروعيته لا تترتب أحكامه المتقدمة، بل يترتب حكم القذف على الزوج لا غير. نعم إذا كانت المرأة خرساء تحرم مؤبداً بمجرد القذف وإن لم يشرع اللعان كما تقدم، وفي انتفاء الولد بذلك إشكال.
(مسألة ١٨١): إذا أقر بالولد قبل أن يقذف اُمه اُلزم به، ولا يقبل منه نفيه حتى باللعان.
(مسألة ١٨٢): إذا أقر الملاعِن بالولد بعد أن ينفيه منه باللعان اُلحق به، فيرث الولد منه ومن قرابته، لكنهم لا يرثونه، بل يبقى ميراثه لاُمه ومن يتقرب به.
(مسألة ١٨٣): إذا أكذب أحدهما نفسه بعد حصول اللعان منهما لم يرتفع
التحريم بينهم، ولو كان الذي أكذب نفسه هو الرجل لم يجب عليه حد القذف.
(مسألة ١٨٤): إذا ادعت الزوجة أو المطلقة الحمل من الزوج فأنكر الدخول بها فالقول قوله، وله نفي الولد بلا لعان. نعم إذا أقامت بينة على أنه اختلى بها خلوة يمكن معها الدخول عادة حكم به واُلحق به الولد، وتوقف نفيه على اللعان، أو على إقامة البينة على ما يمنع من تولد الولد منه.
والحمد لله رب العالمين
كتاب اليمين والنذر والعهد
جعل الله سبحانه وتعالى على الانسان مجموعة من التكاليف لم يجعلها عليه إلا استصلاحاً له ولمجتمعه، وكثيراً ما لا يقوم الانسان بامتثالها استثقالاً لها أو استهواناً به. لكنه مع ذلك قد لا يكتفي بما جعله الله عليه حتى يجعل على نفسه - بيمين ونحوه - ما لم يجعله الله تعالى عليه ويتكلف ما لم يكلفه به، أملاً في تيسير عسر ضاق به ذرعاً أو تفريج كرب جزع له قلبه هلعاً أو لغير ذلك من الدواعي، مستسهلاً ما جعله على نفسه من أجل ذلك، لقصر نظره وعدم تدبره لعواقب الاُمور، حتى إذا تيسر عسره وانفرج كربه، ووجب عليه ما جعله على نفسه ثقل عليه القيام به. وكان بوسعه أن يتجنب ذلك من أول الامر ويتدبر العاقبة قبل أن يورط نفسه، وكم رأينا من ورط نفسه في نذور وأيمان يعجز عنها لا يدري كيف يخرج منه، ولذا ورد عن أئمتنا (عليهم السلام) كراهة ذلك، فعن الامام الصادق (عليه السلام) أنه قال: «إني لاكره الايجاب، أن يوجب الرجل على نفسه».
وكثيراً ما يتسامح الانسان بعد تحصيل مراده في القيام بما جعله على نفسه ويسوف فيه بنحو قد ينتهي للاهمال والتضييع، مع ما شدد الله تعالى في ذلك. قال عز من قائل: (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيل)، وقال سبحانه وتعالى: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً اُولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم)، وقال عزوجل:
(يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطير).. إلى غير ذلك من الايات الكثيرة، وفي الحديث عن الامام الصادق (عليه السلام) أنه قال: «لا تتعرضوا للحقوق، فإذا لزمتكم فاصبروا له».
إذا عرفت هذ، فجعل الانسان على نفسه لا يلزم إلا باليمين والنذر والعهد. والكلام فيها يكون في ضمن مقدمة وفصول..
مقدّمة
اليمين على قسمين..
القسمالأول: ما يريد به الحالف تأكيد دعواه وما يخبر عنه، كالحلف على وقوع أمر سابق، كأن يقول: والله لقد مطرت السماء أمس، أو: والله قتل زيد عمر. أو تحقق أمر في المستقبل، كأن يقول: والله تمطر السماء غد، أو: والله يموت زيد. أو حصول أمر حالي، كأن يقول: والله هذا بيتي، أو: والله زيد عادل.
(مسألة ١): يجوز من هذا القسم اليمين الصادقة، إلا أن يلزم منها محذور شرعي كالاضرار بمؤمن، فتحرم لذلك.
(مسألة ٢): تكره اليمين بالله تعالى، وإن كان الحالف صادق، بل يستحب ترك طلب الحق إذا توقف على اليمين المذكورة، ففي الحديث: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من أجلّ الله أن يحلف به أعطاه الله خيراً مما ذهب منه». ويتأكد ذلك في المال القليل، وفي بعض النصوص أنه ثلاثون درهماً فما دون، وهي تساوي تسعة وثمانين غراماً من الفضة تقريب.
(مسألة ٣): اليمين التي يثبت بها الحق شرعاً عند الخصومة والتداعي وتسقط بها الدعوى هي اليمين بالله تعالى دون غيره كالقرآن الشريف والكعبة المعظمة والانبياء والائمة صلوات الله عليهم والاولياء، فلا تجب الاجابة إلى
غيرها لو طلبها الخصم. ولابد في ترتب الاثر عليها وسقوط الدعوى بها من أن تقع بطلب من الحاكم الشرعي عند التخاصم إليه. نعم إذا تصالح الخصمان على سقوط حق الدعوى من أحدهما بيمين الآخر كانت اليمين مسقطة للدعوى وإن لم تكن بالله تعالى، ولا بحضور الحاكم الشرعي، بل على النحو الذي يتفقان عليه.
(مسألة ٤): تحرم اليمين الكاذبة بالله تعالى، وهي اليمين على أمر مخالف للواقع، وعن الامام الصادق (عليه السلام) أنه قال: «من حلف على يمين وهو يعلم أنه كاذب فقد بارز الله»، وقد ورد عنهم (عليهم السلام) أنها تقطع النسل وتذر الديار من أهلها بلاقع. بل تحرم اليمين على أمر مشكوك الحصول. كما يحرم الاخبار بأمر مخالف للواقع وبأمر مشكوك الحصول حتى من دون يمين، ومع اليمين يتأكد التحريم، وكلما كان المحلوف به أجلّ كان التحريم آكد. نعم لا كفارة في جميع ذلك، بل ليس على فاعله إلا التوبة. وقد تقدم جميع ذلك في مسألة حرمة الكذب من كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(مسألة ٥): يلحق باليمين الكاذبة قول: (الله يعلم) أو: (علم الله) ونحو ذلك. ففي الحديث عن الامام الصادق (عليه السلام) أنه قال: «من قال: الله يعلم فيما لا يعلم اهتز لذلك عرشه إعظاماً له»، وفي حديث آخر عنه (عليه السلام) أنه قال: «إذا قال العبد: علم الله، وكان كاذباً قال الله عزوجل: أما وجدت أحداً تكذب عليه غيري!».
(مسألة ٦): تجوز اليمين الكاذبة لدفع مظلمة عن النفس وعن المؤمن. بل قد تجب اليمين حينئذٍ، كما إذا كان الضرر اللازم من تركها مهماً يجب دفعه، كما تجب لدفع الحرام إذا اُكره عليه لولا اليمين، كما لو طلب الظالم منه الغناء فيحلف له أنه لا يحسنه، أو طلب منه أن يدفع له مال شخص فيحلف له أنه ليس عنده.
(مسألة ٧): تحرم اليمين بالبراءة من الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) والائمة (عليهم السلام) صادقاً أو كاذب، بل الأحوط وجوباً عموم الحرمة للبراءة من دين الاسلام، أو
أن يقول: أنا يهودي أو نصراني أو نحوهما إن كان كذ.
القسم الثاني من اليمين: ما يقصد به الحالف تأكيد ما يلتزمه على نفسه ويتعهد به من فعل أو ترك، فلابد في متعلقه..
أولاً: من كونه فعلاً اختيارياً للحالف، دون ما هو خارج عن اختياره، كأفعاله السابقة، أو أفعال غيره، أو الحوادث الكونية - كطلوع الشمس ونزول المطر - سابقة كانت أو لاحقة، لامتناع تعهد الحالف بذلك على نفسه، بل اليمين في ذلك كله من القسم الاول.
وثانياً: من ابتناء إخباره به على التزامه به وتعهده بتحقيقه، فلو تجرد عن ذلك، بل كان قصده محض الاخبار عنه لم تكن اليمين عليه من هذا القسم، بل من القسم الاول أيض، كما لو حلف على أنه يأكل هذا اليوم نوعاً من الطعام لتخيل أن أهله قد هيؤوه له، أو على أنه لا يسافر، لتخيل عدم حصول الداعي له للسفر.
ولا تكون اليمين من هذا القسم إلا إذا ابتنى إخبار الحالف بمتعلقها على تعهده والتزامه به على نفسه مؤكداً ذلك باليمين، وهذا القسم من اليمين هو الذي يكون من سنخ النذر والعهد، التي هي محل الكلام، والتي يكون انعقادها سبباً لوجوب متعلقه، ويكون الخروج عنها محرماً موجباً للحنث والكفارة. والكلام في الفصول الاتية إنما هو في شروط الانعقاد وأحكامه.
الفصل الاول
في الحالف والناذر والمعاهد
(مسألة ٨): يشترط في الحالف والناذر والمعاهد البلوغ والعقل والقصد بالنحو الذي يعتد به عند العقلاء، فلا تنعقد من الصبي والمجنون والنائم والساهي والسكران والغالط ونحوهم.
(مسألة ٩): لا ينعقد اليمين والنذر من الغضبان إذا أوقعهما في سورة غضبه، من دون تروٍّ وهدوء أعصاب، وإن كان قاصداً لهما في الجملة. بخلاف العهد، فإنه ينعقد حينئذٍ مع تحقق القصد بنحو معتد به عند العقلاء.
(مسألة ١٠): لا تنعقد اليمين إذا صدرت اندفاعاً بسبب عادة، كما يشيع عند كثير من الناس. بخلاف النذر والعهد، فإنهما ينعقدان حينئذٍ مع تحقق القصد بنحو معتد به عند العقلاء.
(مسألة ١١): لابد في انعقاد هذه الاُمور من الاختيار التام، فلا تنعقد مع الاكراه، كما إذا طلبه إليه من يوعده بفعل ما يضره مع قدرته على تنفيذ ما أوعد به بنحو يخاف تحققه. بل لا تنعقد اليمين إذا وقعت من الحالف لارضاء من يهمه إرضاؤه - كالاب والاُم والزوجة - إذا طلب منه ذلك، بخلاف النذر والعهد، فإنهما ينعقدان مع ذلك إذا لم يبلغا حد الاكراه.
(مسألة ١٢): لابد في انعقاد اليمين من الولد من إذن والده، وفي انعقادها من الزوجة من إذن زوجه، وفي انعقادها من العبد من إذن مولاه، فلو لم يسبق منهم الاذن لم تنعقد، وإن لم تكن منافية لحقوقهم، لا أنها تنعقد ولهم حلّه، وإن كان هو الأحوط استحباب. وأحوط منه أنها لا تنحل حتى بحلّهم، إلا أن
للحالف مخالفتها إذا طلبوا منه المخالفة إذا لم يكن متعلقها واجباً بنفسه، فإن خالفها بأمرهم انحلت، وإن لم يخالفها حتى مات الاب واُعتق العبد وطلقت المرأة أو مات زوجها بقيت على الانعقاد، وحرم على الحالف مخالفته، ووجبت بها الكفارة. كل ذلك مقتضى الاحتياط الاستحبابي. والظاهر ما ذكرناه أولاً من عدم الانعقاد إلا مع الاذن.
(مسألة ١٣): لا يقوم الجد للاب مقام الاب في حكم المسألة السابقة.
(مسألة ١٤): لا يشترط في نذر الولد وعهده إذن أبيه، وإن نذر أو عاهد بدون إذنه لم يكن له حله ولا أمره بالمخالفة. نعم إذا نهاه قبل النذر والعهد عن أمر نهياً يوجب كونه مرجوحاً في حقه - بأن كان الاب في حاجة لترك ذلك الامر مثلاً - لم ينعقد منه نذره ولا العهد عليه، كما أنه لو نهاه بعد النذر والعهد عنه نهياً يوجب كونه مرجوحاً في حقه بطل النذر والعهد.
(مسألة ١٥): يشترط في نذر الزوجة وعهدها إذن الزوج إذا كانا منافيين لحقه وكان مطالباً بالحق، أما إذا لم ينافيا حقه - ولو لعدم مطالبته به - فالظاهر عدم اشتراط إذنه، فيصح منها النذر والعهد حينئذٍ وليس له حلهما ولا أمرها بمخالفتهم.
(مسألة ١٦): إذا حلفت المرأة أو نذرت أو عاهدت ثم تزوجت، لم يبطل يمينها ولا نذرها ولا عهده، حتى لو كانت منافية لحق الزوج، بل ليس له المطالبة بالحق حينئذٍ. نعم تبطل الاُمور المذكورة إذا كانت مطالبة الزوج موجبة لكون مخالفتها خيراً من العمل عليه، لما يأتي. وكذا إذا كان النفوذ حرجياً في حقها بنحو معتد به، لاستلزامه تعطيلها عن الزواج - لعدم إقدام أحد عليها مع نفوذ ما جعلته عليها - وكانت محتاجة للزواج، ولم تكن قد أقدمت على تحمل الحرج المذكور بيمينها أو نذرها أو عهده، لغفلتها عن ذلك أو لتخيلها عدمه.
(مسألة ١٧): ينعقد والنذر اليمين والعهد من الكافر، فإن خالفها حال كفره حنث وانحلت ووجبت عليه الكفارة، لكنها لا تصح منه لانها عبادة، ولا تصح العبادة من الكافر. نعم إذا أسلم سقطت الكفارة، وإن لم يخالفها حتى أسلم لزمته، ووجب عليه العمل عليه. فإن خالفها حنث ووجبت عليه الكفارة، وصحت منه.
الفصل الثاني
فيما ينعقد به اليمين والنذر والعهد
(مسألة ١٨): تنعقد اليمين بالله تعالى سواءً كان بلفظ الجلالة، أم بغيره من أسمائه المختصة - مثل فالق الحب وبارئ النسم - أو المشتركة التي تنصرف إليه، مثل الخالق والرحمن والرحيم، بل حتى التي لا تنصرف إليه - كالجواد والكريم - مع قصده به. بل يكفي ما يدل على الذات المقدسة ولو بغير العربية من اللغات الاُخرى.
(مسألة ١٩): لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى وإن عظم قدره، كالقرآن الشريف والكعبة المعظمة والانبياء والائمة - صلوات الله عليهم - والاولياء. نعم ينبغي رفع قدرها عن أن يحلف بها من دون وفاء، لما فيه من الامتهان لها والاستهوان بشأنه، بنحو قد يبلغ مرتبة التحريم. إلا أن ذلك ليس لانعقاد اليمين بها بنحو يلزم بالحنث بها الكفارة، الذي هو محل الكلام.
(مسألة ٢٠): لا تنعقد اليمين بمثل قدرة الله وعظمته وعلمه، بل حتى حق الله تعالى، إلا أن يقصد به اليمين بالذات المقدسة، كما هو غير بعيد في كثير من الموارد. نعم ينعقد بقول: (لعمرو الله)، لأن المقصود به الذات المقدسة.
(مسألة ٢١): لا تنعقد اليمين بمثل: أشهد بالله تعالى، أو أعزم بالله، أو
علم الله أني أفعل كذ، أو نحو ذلك.
(مسألة ٢٢): لا يكفي في انعقاد اليمين القصد للحلف بالله تعالى ما لم ينطق باللفظ الدال عليه جل شأنه. فإذا قال مثلاً: أحلف أو اُقسم لم ينعقد اليمين، ما لم يقل: أحلف بالله، أو اُقسم بالله.
(مسألة ٢٣): يكفي في اليمين كل ما يدل عليه من فعل، مثل: اُقسم بالله وأحلف بالله. أو اسم، مثل: أيم الله وأيمن الله. أو حرف، مثل: والله وبالله وتالله.
(مسألة ٢٤): تقدم أنه تحرم اليمين بالبراءة صادقاً أو كاذب. لكن لو حلف بالبراءة من الله ورسوله - في القسم الثاني من اليمين الذي هو محل الكلام - انعقد مع بقية الشروط، فإن حنث فعليه إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مدّ من طعام.
كما أن الأحوط استحباباً لمن حلف بالبراءة من دين محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) - بل بكل ما يرجع إلى البراءة من الاسلام - على أمر مرجوح - كقطيعة الرحم - أن يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين، من دون أن تنعقد يمينه. وأما مثل: أنا يهودي أو نصراني إن فعلت كذ، فلا تنعقد به اليمين، ولا تثبت به الكفارة.
(مسألة ٢٥): لابد في انعقاد النذر من جعل الامر المنذور لله تعالى، ولا يكفي فيه جعل المكلف الشيء على نفسه من دون أن يضيفه له تعالى، فلا يكفي أن يقول: علي كذ، أو: جعلت علي كذ، أو نذرت كذ. بل لابد أن يقول مثلاً: لله تعالى علي كذ، أو: علي لله كذ، أو: علي كذا لله، أو: علي لله نذر، أو: نذرت لله علي كذ، أو نحو ذلك. نعم لا يشترط ذكر لفظ الجلالة، بل يقوم مقامه كل ما يدل على الذات المقدسة، نظير ما تقدم في اليمين.
(مسألة ٢٦): يحسن الوفاء بما جعله الانسان على نفسه من الخير من دون أن يضيفه لله تعالى، خصوصاً إذا كان الجعل في مقابل قضاء حاجة، بل يخشى
حينئذٍ من عدم وفاء المكلف أن يرى ما لا يحب في حاجته أو في أمر آخر.
(مسألة ٢٧): يكفي في النذر الصيغة بلفظ الخطاب معه تعالى، كما لو قال مثلاً: لك يا رب علي كذ.
(مسألة ٢٨): يكفي في العهد كل ما يدل على التعاهد مع الله تعالى، مثل: عاهدت الله، أو: علي عهد الله، أو: عاهدتك يا رب، أو نحو ذلك.
(مسألة ٢٩): لابد في انعقاد النذر من اللفظ ولا يكفي عقده في النفس إلا مع تعذر اللفظ لخرس ونحوه، فإن الأحوط وجوباً انعقاده مع الإشارة الدالة عليه. أما العهد ففي توقف انعقاده على اللفظ إشكال، فلا يترك الاحتياط بترتيب الاثر على عقده في النفس.
(مسألة ٣٠): لا ينعقد النذر والعهد لغير الله تعالى، كالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والائمة (عليهم السلام) والاولياء والمشاهد الشريفة، فلا يجب الوفاء به شرع، لكنه وعد يحسن الوفاء به، خصوصاً بلحاظ رفعة مقام الموعود وعظيم شأنه، حيث قد يكون عدم الوفاء به منافياً لاحترامه، ولا سيما إذا كان معلقاً على تحقيق مطلوب شفاعته عند الله تعالى أو عظيم حقه عنده، حيث قد يكون عدم الوفاء هضماً لحق عرفي له، بل يخشى من مغبة ذلك وعاقبته.
الفصل الثالث
في متعلق اليمين والنذر والعهد
(مسألة ٣١): يشترط في متعلق اليمين والنذر أن يكون طاعةلله تعالى، من فعل واجب أو مستحب وترك حرام أو مكروه، فلا ينعقدان على ترك واجب أو مستحب ولا على فعل حرام أو مكروه، كما لا ينعقدان على فعل مباح أو تركه. نعم ينعقدان على فعله لو صار راجحاً شرعاً بعنوان ثانوي، ولو لامر
يعود للدني، كما ينعقدان على تركه لو صار مرجوحاً شرعاً بعنوان ثانوي أيض.
وهكذا الحال في متعلق العهد، إلا أن الأحوط وجوباً انعقاده على المباح الذي لا رجحان فيه شرع.
(مسألة ٣٢): إذا انعقد النذر واليمين والعهد لتحقق الشرط المذكور في المسألة السابقة ثم طرأ ما يقتضي رجحان مخالفتها شرع، بحيث يصير متعلقها مرجوح، كان له مخالفتها ولا كفارة حينئذٍ، وإن كان ذلك الطارئ راجعاً للدني، كحفظ المال والتحبب للناس ونحوهما مما هو راجح شرع.
(مسألة ٣٣): لابد في متعلق اليمين والنذر والعهد من أن يكون مقدوراً في وقته، فإن لم يكن مقدوراً في وقته لم تنعقد. وإن اعتقد المكلف القدرة عليه ثم ظهر عدمها انكشف عدم الانعقاد من أول الامر. أما إذا تجدد العجز عنه في أثناء وقته قبل الوفاء - كما لو نذر مثلاً أن يزور الحسين (عليه السلام) في شهر رمضان، فتجدد العجز عن الزيارة من نصف شهر رمضان إلى آخره - فهو لا يمنع من انعقاد اليمين والنذر والعهد، بل يوجب انحلالها من حينه. وحينئذٍ إن ظهرت أمارات العجز قبل وقته وجبت المبادرة للاداء ما دام قادر، فإن فرّط عامداً كان حانثاً ووجبت الكفارة، وإن لم تظهر أمارات العجز حتى فاجأه كان من موارد الحنث غير المتعمد الذي لا كفارة فيه.
(مسألة ٣٤): إذا كان المتعلق أمراً مقيداً فعجز المكلف عن القيد دون المقيد، فإن كان القيد مقوماً للمتعلق عرفاً - كما لو حلف أن يعتمر عمرة رجبية، أو نذر أن يزور الحسين (عليه السلام) في عرفة - كان من موارد تعذر المتعلق الذي تقدم في المسألة السابقة. أما إذا لم يكن القيد مقوماً للمتعلق عرف، بل موجباً لخصوصية فيه زائدة فالأحوط وجوباً الإتيان بالمتعلق الفاقد للقيد، كما لو حلف أن يحج أو يزور ماشي، أو على غسل، أو راكباً سيارة خاصة، أو مع جماعة خاصة، أو نحو ذلك. بل لو أمكن التبعيض في القيد فالأحوط وجوباً الإتيان بما تيسر منه،
كما لو قدر على أن يمشي في بعض الطريق في المثال السابق.
(مسألة ٣٥): يستثنى مما تقدم - من اشتراط القدرة على المتعلق - ما إذا نذر صوم يوم معين، كأول خميس من الشهر، فاتفق أن سافر، أو مرض في ذلك اليوم، أو صادف ذلك اليوم عيد، أو أيام التشريق لمن كان بمنى كان عليه قضاؤه. بل هو الأحوط وجوباً في بقية الاعذار، كالحيض والنفاس. أما إذا تعذر الصوم رأساً - معيناً كان أو مطلقاً - فالأحوط وجوباً أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام.
(مسألة ٣٦): إذا حلف أو نذر أو عاهد على أمر يتعلق بغيره ممن لا ولاية عليه شرعاً لم ينعقد اليمين، كما إذا حلف الاب على أن يزوج ولده الكبير من فلانة، أو يشتري الولدُ الدارَ الفلانية، أو نذرت الاُم أن تزوج بنتها علوي. إلا أن يرجع ذلك إلى ما له الولاية عليه، مثل أن يحلف على أن يقوم بالزواج إذا طلبه الولد أو رضي به، أو على إقناعه بالزواج مع قدرته عليه، فينفذ ذلك منه إذا تمت الشروط الاُخرى.
(مسألة ٣٧): إذا حلف أو نذر أو عاهد على أمر له الولاية عليه شرعاً كان النفوذ مشروطاً بكون المتعلق صلاحاً للمولى عليه على ما هو مقتضى ولايته، وإلا فلا نفوذ، وإن كان الامر راجحاً من بعض الجهات، كما إذا خطب إليه مؤمن ابنته الصغيرة فحلف أن يزوجه إياها مراعياً استحباب قضاء حاجة المؤمن ولم يكن الزواج صلاحاً للبنت. كما أنه لو كان صلاحاً للمولى عليه ثم خرج المولى عليه عن ولايته قبل التنفيذ انحل النذر أو اليمين أو العهد، ولم يجب على المولى عليه بعد أن استقل بنفسه العمل بمقتضاه، فإذا حلف الاب - مثلاً - على تزويج ابنته من شخص وهو يرى ذلك صلاحاً له، فلم يزوجها حتى كبرت أو مات الاب، لم يجب عليها العمل باليمين. وإنما ذكرنا ذلك - مع أنه عند الفقهاء من الواضحات التي لا تحتاج للبيان - لتوهم كثير من عامة الناس
النفوذ حينئذٍ، ووقوع بعضهم في الحرج منه ومحاولتهم المخرج منه.
(مسألة ٣٨): لا تنعقد يمين المناشدة، وهي الحلف على الغير أن يفعل، كما لو قال الرجل لآخر: والله لتفعلن كذ، أو: بالله عليك لتفعلن كذ، أو نحو ذلك، فلا يجب على المخاطب أن يفعل، ولا على الحالف أن يقنعه، ولو لم يفعل لم تجب على أحدهما الكفارة. ويجري ذلك في النذر والعهد.
(مسألة ٣٩): متعلق اليمين والنذر والعهد على قسمين..
الأول: أن يكون منجز، كما لو قال: والله أزور الحسين، أو:لله علي أن أصوم عشرة أيام، أو: عاهدت الله أن لا أفعل محرم، سواءً كان ذلك لمحض الرغبة في إلزام نفسه بالخير، أم شكراً على نعمة حاصلة، أو دفعاً لبلية مخوفة، أو تكفيراً عن خطيئة حاصلة، أو غير ذلك. من دون أن يؤخذ ذلك في اليمين أو النذر أو العهد.
الثاني: أن يكون معلقاً على أمر، مثل أن يقول: والله أزور الحسين (عليه السلام) إن رزقت ولد، أو:لله علي إن شفيت من مرضي أن أصوم عشرة أيام، أو: إن خرج ولدي من السجن فعلي عهد الله تعالى أن اُصلي صلاة الشكر.
والظاهر النفوذ في القسم الاول مطلق، كما لا إشكال في نفوذ الثاني في الجملة وما يأتي تفصيله في المسألة اللاحقة.
(مسألة ٤٠): لا ينعقد النذر واليمين والعهد مع التعليق في موردين..
الأول: إذا كان شكراً على معصية ولو مكروهة كما إذا قال: إن قتل عمرو فلله علي أن اُصلي ركعتين، وكان عمرو مؤمن. أو: والله إن أجاد ولدي الغناء ذبحت شاة وتصدقت بلحمه، ونحو ذلك. وكذا إذا قال: إن قتلت عمراً فلله علي أن أصوم، قاصداً بذلك الشكر على تيسير ذلك له. أما إذا قصد زجر نفسه بذلك والتكفير به عن خطيئته فهو خارج عن ذلك، بل يكون زجراً عن المعصية وينعقد حينئذٍ.
الثاني: إذا كان زجراً عن طاعة كما إذا قال: إن صليت جماعة فلله علي الصدقة بمد من طعام، أو: والله إن صليت جماعة لاتصدقن بمد من طعام، قاصداً بذلك زجر نفسه عن الصلاة جماعة. أما إذا قصدالشكر على تيسير ذلك له فهو خارج عن ذلك، بل يكون شكراً على الطاعة وينعقد حينئذٍ.
وتنعقد فيما عدا ذلك، سواءً كان زجراً عن معصية أو شكراً على طاعة، كالمثالين المتقدمين، أم شكراً على نعمة غير الطاعة، كما لو قال: إن ولد لي ولد فلله علي أن أصوم شهر، أم كان خارجاً عن ذلك ولم يقصد به إلا التوقيت، كما إذا قال: إن دخل الليل فلله علي أن أتصدق بدرهم، أو: والله لاتصدقن بدرهم إن دخل الليل، أو: علي عهد الله أن أتصدق بدرهم إن دخل الليل.
(مسألة ٤١): إذا انكشف مع التعليق حصول المعلق عليه قبل اليمين أوالنذر أوالعهد لم ينعقد شيء منه، فإذا حلف - مثلاً - أن يصوم عشرة أيام إن رزق ولد، ثم علم بعد ذلك أنه قد رزق الولد قبل زمان الحلف انكشف عدم انعقاد اليمين ولم يجب عليه شيء، إلا أن يكون المعلق عليه هو مطلق وجود الشرط وإن كان سابق.
(مسألة ٤٢): إذا علق اليمين أو النذر أو العهد على المشيئة، فقال مثلاً: والله أزور الحسين إن شاء الله تعالى، أو استثنى، فقال: أزور الحسين إلا أن يشاء الله، انحل النذر أو اليمين أو العهد، فلا حنث بمخالفتها ولا كفارة. نعم لو قصد تعليق وقوع الفعل في الخارج مع إطلاق التعهد به فلا انحلال، بل يجب الوفاء، ويقع الحنث بتركه وتجب الكفارة، كما لو قصد في المثال السابق الحلف على زيارة الحسين (عليه السلام) والتعهد بها مطلق، وإن كانت لا تقع في الخارج إلا مع المشيئة. لكن ذلك محتاج إلى عناية لا تناسب تركيب الكلام، بل الكلام بطبعه يقتضي الاول، وهو أن الامر المتعهد به هو المعلق على المشيئة، لا المطلق.
وقد ورد في عدة أحاديث أن من لم يستثن في يمينه كان له أن يستثني متى ذكر ولو بعد أربعين يوم. ولا إشكال في رجحان ذلك، إلا أن في انحلال اليمين به وعدم حصول الحنث وسقوط الكفارة به إشكال، والأحوط وجوباً العدم. بل لا إشكال في عدم الانحلال بذلك في النذر والعهد.
(مسألة ٤٣): إذا نذر ولم يعين شيئاً لم ينعقد النذر ولم يجب عليه شيء، كما إذا قال: إن ولد لي ولد فلله علي نذر.
(مسألة ٤٤): إذا كان متعلق اليمين والنذر والعهد مطلق الطاعة كان له الاقتصار على أدنى البر، من صلاة أو صيام أو صدقة أو غيره.
(مسألة ٤٥): إذا كان المتعلق لهذه الاُمور مجملاً مردداً بين الاقل والاكثر اقتصر على الاقل، وإذا كان مردداً بين المتباينين وجب الجمع بينهم، إلا أن يكون فيه ضرر مهم فالأحوط وجوباً الرجوع للقرعة، وكذا الحال إذا نسي المعلق وتردد بين الاقل والاكثر أو المتباينين. نعم إذا كانت الاطراف كثيرة غير منحصرة فالظاهر الانحلال.
(مسألة ٤٦): من نذر أن يصوم حيناً كان عليه صيام ستة أشهر، ومن نذر أن يصوم زماناً كان عليه صيام خمسة أشهر، والأحوط وجوباً جريان ذلك في اليمين والعهد. نعم إذا قصد بأحدهما مقداراً معيناً كان العمل على ما قصد، حتى في النذر.
(مسألة ٤٧): من نذر شيئاً للكعبة أو المشهد، فإن أمكن الانتفاع به بعينه في مصالح الكعبة أو المشهد من سراج وفراش وتنظيف وعمارة تعيّن، وإلا بيع وصرف ثمنه في ذلك. وإن تعذر الانتفاع به في ذلك - ولو لظهور خيانة السدنة أو عجزهم عن الحفظ بوجه غير متعارف - صرف للمحتاجين من القاصدين والزائرين للكعبة والمشهد في الطعام ونفقة الطريق ونحوهم.
أما مع نذر المال للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الامام (عليه السلام) أو الولي بشخصه فإنه ينفق في القربات والمبرات ويجعل ثوابها للمنذور له، لانه أظهر وجوه انتفاعه بالمال. إلا أن يكون الناذر قد قصد وجهاً آخر من الانفاق، فيتبع قصده. نعم نفوذ النذر في جميع ذلك مشروط بجعله لله تعالى، وإلا كان من النذر لغيره الذي يجري فيه ما سبق.
(مسألة ٤٨): ورد في الحديث الصحيح أن من مرض فاشترى نفسه من الله تعالى بمال إن هو عافاه من مرضه فعوفي أن المال يكون لله تعالى، ومنه للامام (عليه السلام) ، وحينئذٍ يلحقه حكم سهم الامام (عليه السلام) ويراجع به الحاكم الشرعي. والأحوط وجوباً صرفه في الفقراء والمساكين وابن السبيل.
(مسألة ٤٩): كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعة، وكذا كفارة النذر حتى نذر الصوم، على ما تقدم في كتاب الصوم. وكفارة العهد عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكين، لكل مسكين مد من طعام. وقد تقدم في كتاب الصوم كثير من الفروع المتعلقة بالتتابع في الصوم، وبالاطعام، وهي تجري هن. فراجع.
(مسألة ٥٠): الكسوة ثوب تام، والافضل بل الأحوط استحباباً ثوبان.
(مسألة ٥١): إنما تجب الكفارة بتعمد الحنث، وهو المخالفة، ولا تجب مع المخالفة لا عن عمد، نعم هي موجبة لانحلال اليمين والنذر والعهد مع إطلاق متعلقها على ما تقدم. كما لا تشرع الكفارة قبل المخالفة من أجل أن ينحل اليمين والنذر والعهد، وتسوغ مخالفته، بل هي لا تنحل بدفع الكفارة من دون مخالفة.
والحمد لله رب العالمين
كتاب الكفارات
وفيه فصلان..
الفصل الأول
في تعداد الكفارات
ذكرنا جملة من الكفارات في مواضعها المناسبة، فقد تقدمت كفارة إفطار شهر رمضان وكفارة قضائه في كتاب الصوم، وكفارة الجماع حال الاعتكاف في كتاب الاعتكاف، وكفارة الظهار والايلاء في مبحثهم، وتقدمت في كتاب اليمين والنذر والعهد كفاراته. وذكرنا في مناسك الحج والعمرة كفارات الاحرام على كثرته. وذكرنا في المواضع المذكورة الفروع المناسبة له، فلا نطيل بإعادته.
(مسألة ١): كفارة قتل المسلم عمداً كفارة جمع - حتى لو كان عبداً للقاتل الأحوط وجوباً - وهي عتق رقبة مؤمنة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد. وإذا كان القتل فى حرم مكة المعظمة أو في الاشهر الحرم - وهي شهر رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم - لزم الصوم في الاشهر الحرم، وإنما تجب الكفارة بقتل العمد على القاتل إذا لم يقتص منه ورضي أولياء المقتول بالدية.
(مسألة ٢): كفارة قتل المسلم خطأً مرتبة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً لكل مسكين مد. لكن إذا كان القتل في حرم مكة المعظمة أو في الاشهر الحرم فكفارته صوم شهرين متتابعين
من اشهر الحرم، فإن عجز أعتق رقبة مؤمنة، فإن عجز أطعم ستين مسكين.
(مسألة ٣): إنما تجب الكفارة في قتل الخطأ إذا صح نسبة القتل للشخص عرف، دون بقية أسباب الضمان المذكورة في الديات، كما لو حفر بئراً في الطريق غفلة عما يترتب على ذلك فوقع فيها شخص فمات.
(مسألة ٤): لابد في كفارة قتل العمد والخطأ في الحرم أو في الاشهر الحرم من أن يكون الصوم في الاشهر الحرم، وأن يكون التتابع فيه في تمام الشهرين، ولا يكفي التتابع في شهر ويوم ثم تفريق الصوم. ولازم ذلك صوم يوم عيد الاضحى، ولا بأس به، كما تقدم في كتاب الصوم.
(مسألة ٥): إذا اشترك جماعة في قتل شخص واحد،فعلى كل منهم كفارة على الأحوط وجوب.
(مسألة ٦): تثبت كفارة العمد والخطأ في قتل الجنين بعد ولوج الروح فيه، بل مطلقاً على الاظهر.
(مسألة ٧): إذا كان المقتول مهدور الدم بحيث يحل للقاتل قتله - كسابّ الله تعالى وسابّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والائمة (عليهم السلام) - فلا كفارة لقتله. نعم إذا كان مهدور الدم بحد يوكل للامام - كالزاني المحصن واللائط - فلا يجوز لغير الامام قتله إلا بإذن الامام، فإن قتله شخص بغير إذن الامام ثبتت عليه الكفارة.
(مسألة ٨): يحرم على المرأة في المصاب جزّ شعرها - وهو قصّه ونتفه - وخدش وجهها حتى تدميه، وفيها الكفارة. وأما اللطم على الخد فلا كفارة فيه. ويستحب له الاستغفار والتوبة.
(مسألة ٩): كفارة جز الشعر من المرأة في المصاب عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكين، لكل مسكين مد. ويكفي في وجوبها جز بعضه بمقدار معتد به، ويلحق به الحلق.
(مسألة ١٠): كفارة نتف المرأة شعرها في المصاب وخدش وجهها حتى تدميه كفارة يمين.
(مسألة ١١): يحرم على الرجل أن يشق ثوبه في مصابه بولده أو زوجته. ولا يحرم الشق في غير ذلك، كشق الاخ على أخيه وشق المرأة على زوجها والاُم على ولدها والاُخت على أخيها وغير ذلك. وإن كان الاولى ترك ذلك والتجمل بالصبر.
(مسألة ١٢): كفارة شق الرجل ثوبه على ولده أو زوجته كفارة يمين.
(مسألة ١٣): من تزوج امرأة ذات زوج أو في عدتها جاهلاً استحب له التكفير بخمسة أصوع من الدقيق، بل هو الأحوط استحباب. والصاع أربعة أمداد يقارب ثلاث كيلوات وأربعمائة وثمانين غرام، كما تقدم في زكاة الفطرة.
(مسألة ١٤): من نام عن صلاة العشاء حتى انتصف الليل استحب له التكفير بأن يصوم اليوم اللاحق، بل هو الأحوط استحباب.
(مسألة ١٥): ورد أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان، وحمل على الاستحباب. لكن تقدم في كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمة العمل للجائر مع عدم الاكراه إلا أن يكون الغرض نفع المؤمنين.
(مسألة ١٦): ورد أن من اغتاب مؤمناً فكفارته أن يستغفر له، وحمل على الاستحباب. لكن تقدم في كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لزوم الاستغفار له مع تعذر الاستحلال منه.
(مسألة ١٧): ورد في بعض الكفارات المستحبة أن كفارة الطيرة التوكل، وكفارة الضحك أن تقول: اللهم لا تمقتني، وكفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها: (سبحان ربك رب العزة عما يصفون * وسلام على المرسلين * والحمد لله رب العالمين).
الفصل الثاني
في أحكام الكفارات
(مسألة ١٨): لا تثبت الكفارة بفعل شيء من أسبابها إلا إذا كان الفاعل مكلفاً بعدم فعل السبب بأن يكون بالغاً عاقلاً غير مكره إكراهاً رافعاً للتكليف، فإذا قتل الصبي مثلاً مسلماً عمداً أو خطأً فلا كفارة عليه. وكذا إذا اُكره البالغ على الحنث بيمينه.
نعم إذا لم يكن الإكراه رافعاً للتكليف فلا أثر له، بل تجب معه الكفارة، كما إذا اُكره على قتل مسلم، فإن الإكراه لا يسوّغ القتل ولا يسقط كفارته.
(مسألة ١٩): لا تثبت الكفارة بفعل شيء من أسبابها لا عن عمد، بل خطأ أو نسياناً أو جهلاً بالحكم أو الموضوع. إلا كفارة قتل المسلم خطأ على ما تقدم، وكفارة الصيد في الاحرام على ما يذكر في محله.
(مسألة ٢٠): تجب المبادرة إلى أداء الكفارة عقلاً لانها بمنزلة التوبة من الذنب.
(مسألة ٢١): وجوب الكفارات المذكورة تكليف محض، فيجب على المكلف القيام بها من دون أن تكون من سنخ الديون التي تخرج من تركته بعد وفاته. نعم لو أوصى بها خرجت من ثلثه.
(مسألة ٢٢): الكفارات المتقدمة عبادات لابد فيها من نية القربة، فيجري فيها الفروع المناسبة لذلك، المذكورة في محلها كمباحث الوضوء.
(مسألة ٢٣): لما كانت الكفارات من العبادات فهي لا تصح من الكافر
لو تحقق سببها منه وإن وجبت عليه. كما أنه لو أسلم تسقط عنه. وكذا لا تصح من غير المؤمن. لكنه لو استبصر أجزأته كما يجتزئ بسائر عباداته. أما إذا لم يأت بها حتى استبصر فإنها لا تسقط عنه، بل يجب عليه أداؤه. نعم إذا لم يتحقق في حقه شرط ثبوتها فلا شيء عليه، كما إذا أقدم على السبب معتقداً حليته.
(مسألة ٢٤): يكفي في عدم كون المكلف واجداً للرقبة عدم وجدانه من المال ما يفضل عن حاجته وحاجة عياله فعلاً ولا قوة، لعدم قدرته على التكسب بما يزيد على ذلك. وإن كان عدم تيسر العثور على الرقبة في زماننا غالباً يغني عن الكلام في ذلك وفي جميع الفروع المتعلقة به.
(مسألة ٢٥): يكفي في العجز عن الصيام المرض أو الحرج المعتد به إذا لم يرج زوالهما قريب.
(مسألة ٢٦): يكفي في التتابع صوم شهر ويوم، كما تقدم في كتاب الصوم وتقدمت بعض الفروع المتعلقة به. نعم لابد من التتابع التام في صوم كفارة القتل في الحرم أو في الاشهر الحرم عمداً كان أو خط، كما تقدم في الفصل الاول.
(مسألة ٢٧): المراد بإطعام المسكين في الكفارة هو أن يشبعه أو يتصدق عليه بمد من طعام. وقد تقدم في كتاب الصوم الفروع المناسبة لذلك.
(مسألة ٢٨): لا يجوز في إطعام الفقير في الكفارة الدفع لمن تجب نفقته على صاحب الكفارة إلا أن تكون عليه نفقات لا تجب على صاحب الكفارة نظير ما تقدم في الزكاة.
(مسألة ٢٩): المدار في العجز في الكفارة المرتبة على العجز حين إرادة التكفير، فإذا عجز عن المرتبة السابقة فأتى باللاحقة وأتمها ثم قدر على السابقة أجزأه ما أتى به ولا يحتاج للتكفير مرة اُخرى بما قدر عليه من المرتبة السابقة. نعم إذا قدر على المرتبة السابقة قبل إكمال التكفير بالمرتبة اللاحقة فالأحوط
وجوباً عدم الاجتزاء بما أتى به، بل يستأنف التكفير بالمرتبة السابقة، فإذا عجز عن العتق مثلاً فشرع في الصوم ثم قدر على العتق قبل إكمال الصوم أعتق ولم يجتزئ بالصوم الذي وقع منه. نعم تقدم في كفارة الظهار الاجتزاء بالصوم في بعض الصور.
(مسألة ٣٠): من عجز عن بعض الخصال في كفارة الجمع أتى بالباقي، واستغفر بدلاً عما عجز عنه، والأحوط استحباباً أن يتصدق أيضاً بدلاً عنه بما يطيق. بل الأحوط وجوباً مع العجز عن الاطعام فيها أن يصوم ثمانية عشر يوم.
(مسألة ٣١): من عجز في الكفارة المرتبة عن الخصال الثلاث وآخرها إطعام ستين مسكيناً صام ثمانية عشر يوماً عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام. فإن عجز عنها أيضاً لحقه حكم من عجز عن الكفارة من الاجتزاء بالاستغفار بدلاً عنه. والأحوط استحباباً أن يتصدق أيضاً بما يطيق. هذا في غير كفارة الظهار، فقد تقدم الكلام فيها في محله.
(مسألة ٣٢): من كان عليه كفارات متعددة فعجز عن القيام بها كلها أتى بما يقدر عليه منها وجرى على الباقي حكم العجز عن الكفارة. ولا يجري حكم العجز عن الكفارة بالاضافة إلى الجميع، إلا إذا لم يقدر على شيء منه.
(مسألة ٣٣): من عجز عن الكفارة فأتى بالبدل من الاستغفار أو غيره سقطت عن ذمته، فإذا قدر عليها بعد ذلك لم يجب عليه تداركه.
والحمد لله رب العالمين
كتاب الإقرار
وهو إخبار عن حق ثابت على المخبر أو نفي حق له على غيره. وينفذ في حق المقر على نحو لا تسمع منه الدعوى على خلافه، ويقدم على جميع الحجج حتى البينة. ويقع الكلام في شروط نفوذه وأحكامه.
(مسألة ١): يشترط في المقر البلوغ والعقل بالنحو المناسب للرشد في الجهة التي أقر بها من مال أو غيره، فإذا كان رشيداً في جهة دون اُخرى نفذ إقراره في الجهة التي هو رشيد فيها دون الجهة التي ليس رشيداً فيه. فإذا كان رشيداً في الماليات إلا أنه سفيه فيما يتعلق ببدنه لقصور في إدراكه، فلا يهمه مثلاً إتلاف عضو من أعضائه، فأقر بأنه قد قطع يد رجل، لم ينفذ إقراره بنحو يستحق عليه القصاص، بل تثبت الدية لا غير. وقد تقدم في كتاب الحجر تحديد السفه في الماليات بنحو يجري نظيره في غيره. فراجع.
(مسألة ٢): يشترط في المقر أيضاً القصد، فلا ينفذ إقرار النائم والسكران، والساهي والغالط. نعم لما كان السهو والغلط على خلاف الاصل فلابد له من إثباتهم، فإذا لم يثبتهما يحكم بعدمهما ظاهراً فينفذ الاقرار في حق الشاك في تحقق أحدهم، ولا ينفذ في حق العالم بوجوده.
(مسألة ٣): يشترط في المقر أيضاً الاختيار فلا ينفذ الاقرارمن المكره، ولا من المضطر، كما إذا عطش وخاف على نفسه التلف فطلب ماء فامتنع صاحب الماء من أن يعطيه حتى يقر له بأنه قد باعه الدار، فأقر له به، فإن إقراره حينئذٍ لا
ينفذ. نعم لما كان الاكراه والاضطرار على خلاف الاصل فلابد له من إثباتهم، على نحو ما تقدم في المسألة السابقة.
(مسألة ٤): لا يشترط في الاقرار صيغة خاصة، بل يكفي كل ما يدل على ثبوت الحق على المقر للمقر له، أو نفي حقه عليه، ولا يشترط صراحته فيه، بل يكفي ظهوره فيه عرف. بل يكفي الاعتراف بلازم ذلك في ثبوت الملزوم، فإذا ادعى رجل على آخر مال، فادعى الآخر الوفاء، كانت دعواه الوفاء إقراراً منه بسبق استحقاق المدعي للمال عليه، فيلزم بأدائه ما لم يثبت الوفاء. وكذا إذا ادعى الرجل زوجية امرأة فادعت الطلاق، فإن دعواها الطلاق منه إقرار منها بسبق زوجيته له، وهكذ.
(مسألة ٥): إذا لم يتضمن الكلام الاخبار بثبوت الحق أو بلازمه، بل تضمن طلب تصرف يلازم ثبوته، فالظاهر عدم صدق الاقرار عليه بمجرد ذلك، كما إذا رأى في يد زيد عيناً فقال: بعنيه، فإن البيع وإن كان لا يتحقق إلا من المالك إلا أن طلب البيع قد يبتني على كونه صاحب يد محكوم بأنه المالك ظاهر، فلا يقتضي الاقرار بملكيته واقعاً بحيث ليس له بعد ذلك دعوى ملكيته تكذيباً لليد. نعم إذا قامت القرينة على ابتناء طلب البيع على تصديقه في ملكيته مع قطع النظر عن اليد كان ذلك إقرار. بل يجري ذلك حتى في الاخبار بملكية صاحب اليد، فإنه لا يكون إقراراً إلا إذا قامت القرينة على رجوعه إلى الاخبار بالملكية واقعاً مع قطع النظر عن اليد.
(مسألة ٦): لا يشترط في الاقرار اللفظ، بل يكفي كل ما يدل على الاخبار بثبوت الحق أو نفيه من إشارة أو كتابة أو غيرهم.
(مسألة ٧): يشترط في المقر به أن يكون حقاً للمقر له، بحيث له مطالبة المقر وإلزامه به، كالاعيان والمنافع الخارجية والذمية المملوكة والحقوق كحق
الخيار والاستمتاع والانفاق ونحوه. فلو لم يكن كذلك فلا أثر للاقرار به، كما لو أقر أنه قد حلف أن يدفع لزيد عشرة دنانير أو نذر أن يكسوه كسوة الشتاء، لأن اليمين والنذر إنما يجب الوفاء بهما لله تعالى، من دون أن يثبت بهما حق للشخص الذي ينتفع بمضمونهم. وكذا إذا أقر أن عليه حقاً شرعي، فإن ذلك لا يصحح للفقير المطالبة به، لأن الحق ليس ملكاً للفقير، بل هو مصرف له، فليس له المطالبة به إذا لم يدفع له. نعم لو تمت ولاية الحاكم الشرعي على الحق كان له المطالبة به نيابة عن صاحبه.
(مسألة ٨): إذا أقر بثبوت الحق عليه بسبب باطل لم يثبت شيء، كما لو قال: لزيد عليّ ألف دينار من ثمن خمر أو خنزير أو دين ربوي أو نحو ذلك. نعم لو أطلق الاقرار بثبوت الحق، ثم ادعى أن ثبوته كان بسبب باطل، ثبت الحق كما أقر، ولم تسمع منه دعوى بطلان السبب. وهكذا الحال في الاقرار بنفي حقه، كما لو قال: ليس لي عليه شيء بسبب إبرائي لذمته من الدين قبل بلوغي.
(مسألة ٩): لو أقر بدين مؤجل ثبت ما أقر به، ولم يستحق المقر له المطالبة قبل الأجل، إلا أن يثبت المقر له عدم التأجيل في الدين. بخلاف ما لو أقر بالدين وأطلق ثم ادعى التعجيل، فإن مقتضى الاصل في الحق التعجيل إلا أن يثبت من عليه الحق تأجيله.
(مسألة ١٠): المتبع في تحديد الحق المقر به ظاهر كلام المقر المستفاد من إطلاقه أومن القرائن الحالية والمقالية المحيطة بكلامه، فإن ادعى خلاف ذلك لم يسمع منه. إلا أن يقر المقر له بما يشهد بمخالفة ظاهر كلام المقر الاول للواقع. كما لو أقر زيد لعمرو بألف دينار، فإنه يحمل على عملة البلد عملاً بظاهر الكلام ما لم يقر عمرو بأن سبب الاستحقاق عقد قد تضمن التقييد بعملة اُخرى غير عملة البلد، وكذا إذا ادعى وجود القرينة الصارفة عن مقتضى الظهور الاولي،
فإن الدعوى المذكورة تسمع منه ويطالب بإثباته.
(مسألة ١١): إذا أقر بعين تحت يده محكومة بأنها ملكه لشخصين في كلامين لا تعلق لاحدهما بالآخر حكم بأنها لمن أقر له أول. وحينئذٍ إن كذبه الثاني في إقراره بها للاول كان له أن يقيم الدعوى على الاول وإثبات أنها له فينتزعها من الاول إن تيسر له ذلك، وإن لم يتيسر له ذلك كان له أن يقيم الدعوى على المقر بأنه قد تعمد حرمانه منها بإقراره بها للاول، بنحو يكون مفرطاً فيه، فيضمنها له وكذا إذا كان المقر قد سلمها للاول اختيار، حيث يضمنها بعدم تسليمها للثاني الذي هو مالكها بمقتضى إقراره له. أما إذا لم يتيسر له أحد الامرين فلا شيء له على المقر، كما إذا كان إقراره الاول عن خطأ منه أو ادعى هو ذلك من دون أن يتيسر للثاني تكذيبه فيه، وكان دفع العين للاول بإلزام من الحاكم الشرعي أو كان الاول قد انتزعها منه إرغاماً من دون أن يكون هو قد فرط بتسليمها له.
(مسألة ١٢): إذا أقر بعين تحت يده لشخصين في كلام واحد، فإن كان بنحو يظهر في العدول من الاقرار بها للاول إلى الاقرار بها للثاني كان بحكم المسألة السابقة، كما إذا قال: هذا الثوب لزيد، كلا قد نسيت هذا لعمرو. وإن كان بنحو الاضراب الظاهر في الغلط وسبق اللسان حكم بها لمن أقر له بها ثاني، كما إذا قال: هذه الدنانير لزيد، بل لعمرو. وحينئذٍ إن كذبه الاول في إقراره بها للثاني كان له أن يقيم الدعوى على الثاني وإثبات أنها له فينتزعها منه إن تيسر له ذلك، وإن لم يتيسر له كان له أن يقيم الدعوى على أن المقر قد تعمد الاقرار بها له أولاً حقيقة ثم عدل للاقرار بها للثاني ليحرمه منه، وليس ما صدر منه من الخطأ وسبق اللسان، كما هو ظاهر الكلام، فإن تم له إثبات ذلك حكم بها للمقر له أولاً وجرى حكم المسألة السابقة، وإن لم يتم له إثبات ذلك أيضاً فلا شيء له.
(مسألة ١٣): لو أقر بما يتردد بين الاقل والاكثر ثبت الاقل واُلزم به، دون الاكثر.
(مسألة ١٤): لو أقر لشخص بأمر مبهم كلف الخروج عنه بدفع ما يصلح تفسيراً له، فإذا قال: له علي مائة، وترددت المائة بين اُمور، كلف بدفع مائة مما يصلح لأن يملك ويفسر به إقراره.
(مسألة ١٥): لو أقر لشخص مبهم فإن كان مردداً بين أشخاص بعضهم لا يصلح للمطالبة بالحق لغيبة أو لكونه تحت ولاية المقر أو غير ذلك، فلا يلزم بإقراره. وإن كان مردداً بين أشخاص كلهم يصلح للمطالبة بالحق فإن فسر المبهم وعينه قبل منه، وإن لم يفسره لم يكن لكل منهم المطالبة بالامر المقر به ولا بالتفسير. نعم لهم أن يوكلوا شخصاً واحداً - منهم أو من غيرهم - بالمطالبة بإيصال الامر المقر به لصاحبه الواقعي، فله أن يلزمه بذلك، ولا يتسنى له ذلك إلا بتفسير المبهم وتعيين صاحب الحق.
ثم إن فسر صاحب الحق وعينه بشخص خاص حينئذٍ أو من أول الامر، فإن لم يعترض غيره أخذ ذلك الشخص الامر المقر به، وإن اعترض غيره كان خصماً له لا للمقر، فإن أقام البينة على أنه صاحبه انتزعه منه، وإلا كان له على ذلك الشخص اليمين، فله أن يحلف اعتماداً على الاقرار، إلا أن يعلم بخطأ الاقرار أو كذبه فلا يحق له التعويل عليه في أخذ الامر المقر به فضلاً عن اليمين عليه.
(مسألة ١٦): إذا أقر إقراراً يلزم شرعاً بظاهر الحال ثم ادعى أن إقراره لم يكن بداعي بيان الواقع، فإن رجع ذلك إلى خلل في شروط الاقرار، كما لو ادعى الاكراه أو الاضطرار أو الغلط، سمعت دعواه وكان عليه الاثبات، فإن لم يثبت نفذ الاقرار في حقه. وإن رجع إلى كذب الاقرار من دون خلل في شروطه لم تسمع دعواه، كما إذا أقر بالبيع أو بقبض الثمن وأشهد على إقراره، ثم ادعى
ابتناء إقراره على المواطأة مع الطرف الآخر من أجل تنظيم المعاملة رسمياً وتثبيت شهادة الشهود عليها من دون أن يتحقق المقر به بعد في الواقع. ومجرد تعارف ذلك بين الناس وكثرة وقوعه لا يكفي في سماع الدعوى بعد رجوعها إلى تكذيب الاقرار.
(مسألة ١٧): الاقرار حجة في حق كل أحد، ولا تختص حجيته بالحاكم الشرعي، ولا يتوقف نفوذه في حق غيره على حكمه.
(مسألة ١٨): الاقرار حجة ظاهرية، إنما ينفذ مع احتمال الصدق، فلو علم بكذبه لم ينفذ ولم يجز ترتيب الاثر عليه. نعم هو مقدم على جميع الحجج الظاهرية.، بل لا تسمع معه الدعوى على خلافه من المقر، كما تقدم.
(مسألة ١٩): إذا أقر لشخص بشيء فإن صدقه المقر له أو قال: لا أعلم، نفذ الاقرار. وإن كذبه لم ينفذ لتعارض الاقرارين المسقط لهما عن الحجية، وحينئذٍ يرجع للحجج الاُخرى المتأخرة عن الاقرار، كالبينة واليد والاصل.
تتميم..
يقبل الاخبار من بعض الاشخاص في بعض الموارد كحجة معتبرة، وقد يطلق عليه في كلماتهم الاقرار. لكنه ليس إقراراً بالمعنى المتقدم، لعدم ابتناء قبوله على تضمنه الاعتراف بحق على المقر..
منها: إخبار الانسان عما تحت يده مما ليس ملكاً له كالامانة والمغصوب، فإنه يرجع إليه في أمره ويقبل قوله فيه، فإذا أقر بأنه ملك لانسان حكم له به، وكذا إذا أخبر بأنه وقف أو حق شرعي أو نحو ذلك. بل لو أخبر بأنه محقوق لغير المالك قبل منه، كما لو ادعى أنه رهن على دين أو مستأجر إلى أجل أو
نحوهم. وكذا إذا ادعى أنه عارية أو وديعة إلى غير ذلك. نعم إذا كذبه المالك أو من أقر هو بأنه المالك كان قوله مقدم. كما أن حجية خبره فيه ليس كحجية الاقرار الذي سبق أنه يقدم على جميع الحجج، بل تقدم البينة عليه، كما يقدم عليه قول من ثبت سبق يده عليه.
ومنها: أن من كان له السلطنة على شيء يقبل منه إخباره به في الظاهر، كإخبار الزوج بطلاق زوجته، وإخبار الولي أو الوكيل بفعل ما له الولاية عليه أو وكل فيه، وإخبار الاجير على تفريغ ذمة الغير بإتيانه بالعمل المستأجر عليه، إلى غير ذلك. وهو المعروف عند الفقهاء«رض» بأن من ملك شيئاً ملك الاقرار به. نعم يمكن رفع اليد عنه بحجة منافية، كالبينة.
ومنها: الاقرار بالنسب، حيث يقبل في بعض الموارد على ما تقدم في فصل أحكام الاولاد من كتاب النكاح، مع أنه قد يستلزم أحكاماً ليست من سنخ الحقوق الثابتة على المقر، كميراث المقر ومن يتقرب به ممن يدعي بنوته، وميراث الولد المدعى من المقر وممن يتقرب إليه به... إلى غير ذلك من الموارد التي يقبل فيها إخبار الانسان من دون أن يكون إقراراً بالمعنى المتقدم.
والحمد لله رب العالمين
كتاب الغصب
وهو العدوان على ملك الغير واستلابه بدون حق شرعي، بل لمجرد القدرة عليه، وبه يخرج الانسان عن إنسانيته الفاضلة إلى حيوانيته وبهيميته، حيث يقهر القوي الضعيف من دون أن يصغي إلى وازع من ضمير ولا يرتدع برادع من دين.
وقد حرمه الله تعالى استصلاحاً للانسان، وتنظيماً للعلائق بين أفراده بما يناسب إنسانيته. بل تقدم في كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أن من الكبائر حبس الحقوق، وفي الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «من أخذ أرضاً بغير حق كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر»، وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «أعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق». بل في آثاره في الدنيا ما يصلح أن يكون رادعاً لذي الرشد والحج، فعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «الحجر الغصب في الدار رهن على خرابه».
ويلحق به في أكثر الاحكام في محل الكلام الاستيلاء على مال الغير بغير حق لا بنية العدوان، بل خطأ أو لتخيل الاستحقاق، كالمقبوض بالعقد الفاسد ونحوه. ومن ثم يكون موضوع الكلام هنا ما يعم ذلك، وهو الاستيلاء على مال الغير من دون استحقاق واقعي، سواءً كان على وجه الظلم وبنحو العدوان أم مع العذر. وإذ اختص بعض الاحكام بصورة العدوان أشرنا إلى اختصاصه به عند التعرض له.
(مسألة ١): يحرم غصب المال المملوك والذي يختص بجهة معينة، كالحق الشرعي والمال الموقوف وغيره. بل يحرم غصب المال غير المملوك لمحترم المال إذا كان فيه حق الاختصاص بتحجير ونحوه. نعم لا يحرم غصب مال من لا يحترم ماله والمال المملوك لمحترم المال إذا سقطت حرمته ووجب عليه إتلافه فلم يتلفه.
(مسألة ٢): يحرم غصب الحر إذا كان محترم الدم وكان في غصبه منافاة لسلطنته إذا كان كاملاً تام السلطنة، أو لسلطنة وليه عليه إذا كان قاصراً مولى عليه. نعم لا يضمن بمجرد الغصب، بل بالاتلاف. وإنما تضمن منافعه التي يستوفيها الغاصب كما لو استخدمه. وأما التي لم يستوفها فلا ضمان لها إلا أن يكون أجيراً مملوك المنفعة لشخص آخر ففي الضمان إشكال.
(مسألة ٣): يتحقق غصب الانسان للعين باستيلائه عليه، بحيث تكون في حوزته. ولا يكفي فيه منعه للمالك من الاستيلاء عليه، كما لو منع المالك من إمساك دابته فشردت أو تلفت أو غصبت، فإنه لا يكون غاصباً بذلك ما لم يستول هو عليه. نعم يكون ضامناً لها إذا استند تلفها إليه عرف، كما لو اندفعت فأمسكها المالك ففتح يد المالك أو قطع الحبل فاسترسلت حتى تردت. وكذا لو كان المالك قد ربطها ففك الرباط أو قطع الحبل، بخلاف ما إذا فك الرباط أو قطع الحبل فلم تندفع بل وقفت ثم مشت حتى تردَّت أو تلفت بسبب آخر كغرق أو أكل سبع أو نحوهم. ويأتي في آخر كتاب القصاص والديات التعرض لاسباب الضمان. وعلى كل حال فالضمان حينئذٍ ليس للغصب، بل للاتلاف.
(مسألة ٤): لا فرق في تحقق الغصب بالاستيلاء بين الاعيان المنقولة والثابتة، كالدار والعقار والبستان وغيره.
(مسألة ٥): لا يتحقق غصب العين بمجرد التصرف فيها من دون استيلاء عليها واستقلال به، كما لو دخل الدار أو صعد في السيارة أو جلس
على الفراش، بل غاية الامر أنه يكون غاصباً للمنفعة، فيضمنها لو كان لها مالية، من دون أن يضمن العين ذات المنفعة.
(مسألة ٦): إذا سكن شخص مع المالك في الدار مراغماً له فلذلك صور..
الاُولى: أن يشغل موضعاً من الدار من دون أن يستقل به ولا بالدار، بل يبقى الاستقلال للمالك، بحيث يستطيع المالك نقله من موضع لآخر، نظير النزيل في الفندق. وفي ذلك لا يكون غاصباً للدار بل لمنفعتها لا غير.
الثانية: أن يستقل بالقسم الذي يسكنه بحيث يفقد المالك السيطرة عليه مع بقاء سيطرته على الباقي منه. وحينئذٍ يكون غاصباً للقسم الذي استولى عليه دون الآخر، وإذا كان هناك موضع مشترك بينهما يلحقه ما يأتي.
الثالثة: أن لا يختص كل منهما بشيء منه، بل يشتركان في الاستيلاء على تمام الدار، كالشريكين. وفي صدق الغصب هنا لعين الدار إشكال، كالاشكال في ضمانه، والمتيقن صدق الغصب بالاضافة إلى المنفعة وضمانه.
الرابعة: أن يستولي على تمام الدار ويستقل به، ويكون المالك هنا كالغاصب في الصورة الاُولى. وحينئذٍ يكون غاصباً لتمام الدار، ولما يستوفيه هو من منافعه، دون ما استوفاه المالك من منافعه.
وتجري الصور الاربع فيما إذا غصبت الدار من المالك وأشغلها أكثر من واحد، فإن ضمان كل منهم تابع لاستيلائه على ما فصل في الصورة المذكورة. وتجري أحكامها عدا الصورة الثالثة، فإن الغصب فيها يستند للمجموع لا لكل واحد، فيكون ضمان الدار عليهم بنحو التوزيع.
(مسألة ٧): لا وكالة في الغصب، فإذا باشر الوكيل الغصب كان هو الغاصب والضامن دون الموكل. إلا أن يباشر الموكل الغصب بنفسه أيض.
(مسألة ٨): العين المغصوبة مضمونة على الغاصب بمجرد وضع
يده عليه، سواءً كان معتدياً في ذلك أم ل. فيجب عليه ردها إلى مالكها مع وجودها وإن كان شاق. وإذا استلزم صرف مال كان عليه.
(مسألة ٩): إذا حدث في العين عيب أو نقص كان مضموناً على الغاصب فيدفع مع العين الارش، وهو فرق ما بين الصحيح والمعيب بحسب القيمة السوقية. نعم الارش الشرعي مع تلف عين الدابة هو ربع قيمته.
(مسألة ١٠): إذا زادت العين عند الغاصب زيادة متصلة - كالسمن - أو منفصلة - كالبيض واللبن - كانت للمالك مضمونة على الغاصب فيجب عليه ردها مع العين أو رد بدلها لو كانت قد تلفت. نعم لو لم يستول الغاصب على الزيادة ولم تصر تحت يده لم يضمنه، كما لو طار الطائر المغصوب من الغاصب، فتكونت فيه بيضة وباضها ثم رجع للغاصب. بل يكون الضمان على من يستولي على الزيادة المذكورة.
(مسألة ١١): إذا استحالت العين المغصوبة في يد الغاصب كالبيضة تصير فرخاً والحب يصير زرع، فالامر المستحال إليه للمالك، فإن نقصت قيمته عن الاصل كان على الغاصب الارش. وكذا الحال لو انقلب الخل خمراً ثم انقلبت الخمر خل.
(مسألة ١٢): إذا ارتفعت قيمة العين بأمر أحدثه الغاصب فيه، و كانت الزيادة بسبب إضافة عين - كما لو وضع للثوب أزراراً - كان له انتزاعها ما لم يضر بالعين المغصوبة، فإن كان مضراً بها فالأحوط وجوباً حينئذٍ التصالح مع المالك والاتفاق معه إما على أخذ المالك الزيادة بقيمته، أو إبقائها في العين بانتظار بيعها ودفع ما يقابل الزيادة من الثمن لمالكه، أو انتزاع الغاصب عينه وضمان نقص العين المغصوبة أو غير ذلك.
(مسألة ١٣): إذا ارتفعت قيمة العين بأمر أحدثه الغاصب وكانت
زيادتها مسببة عن حدوث صفة - كصبغ الثوب أو غسله وتجفيف الطعام أو طبخه وصياغة الذهب - فلا شيء للغاصب، بل يجب عليه دفع العين للمالك، وكذا إذا كان مسبباً عن عين لا تميز لها في مقابل العين المغصوبة، بل تعد عرفاً تالفة فيها كالدهن في الطعام. نعم إذا لم يكن الغاصب معتدياً بل أخذ العين وتصرف فيها بتخيل الاستحقاق، فالظاهر أنه يملك نتيجة عمله ولا يجوز لمالك العين تفويته عليه، فإذا بيعت العين كان له من الثمن ما يقابل الصفة ونحوها بالنسبة. فإذا كانت قيمة الذهب مثلاً عشرة وقيمة الصياغة خمسة، فبيعت العين مع الحفاظ على النسبة كان له من الثمن الثلث.
(مسألة ١٤): إذا زرع الغاصب الارض المغصوبة أو بنى فيها كان عليه اُجرة الارض في المدة المذكورة وله زرعه وبناؤه وللمالك أمره بقلعه وإن تضرر بذلك، وعليه الارش للمالك لو تضررت الارض بحفر أو أملاح أو نحوهم. نعم إذا لم يكن الغاصب معتدي، بل تصرف في العين بتخيل الاستحقاق كان له إلزام صاحب الارض بإبقاء ما جعله فيها بالاُجرة، إلا أن يتضرر صاحب الارض فله قلعه حينئذٍ، أو يصطلحان على وجه آخر.
(مسألة ١٥): إذا امتزجت العين المغصوبة عند الغاصب بمال للغاصب امتزاجاً رافعاً للتمييز بينهما عرف، جرى على المالين حكم الشركة، كما يظهر مما تقدم في كتاب الشركة. والظاهر أن حصة كل منهما من المجموع بنسبة قيمة كل من المالين لقيمة المجموع، لا بنسبة مقدار ماله لمقدار المجموع، فإذا تساوى المالان قدراً وكانت قيمة مال أحدهما ضعف قيمة مال الآخر كان لصاحب الاول الثلثان ولصاحب الثاني الثلث. وإن اشتبهت القيمة لزم الرجوع للصلح. وحينئذٍ إن نقصت قيمة المال المغصوب بسبب الامتزاج كان الغاصب ضامناً للنقص. كما أنه إن أمكن الفصل بين المالين كان للمالك مطالبة الغاصب به فيجب عليه القيام به، وإن استلزم صرف مال كان عليه، وإن تعذر فالظاهر
عدم استحقاق المالك إلزام الغاصب بدفع البدل، خصوصاً إذا رفع الغاصب يده عن ماله وأباحه له.
هذا كله إذا كان الغاصب معتدي، أما بدون ذلك فليس للمالك إلزامه بتمييز المالين إذا استلزم صرف مال، نعم له القيام بذلك بنفسه.
(مسألة ١٦): إذا نزلت قيمة العين السوقية من دون نقص فيها لم يكن على الغاصب شيء، بل يكفيه دفع العين.
(مسألة ١٧): لما كانت العين المغصوبة مضمونة على الغاصب فاللازم عليه مع تلفها رد بدلها على المالك.
(مسألة ١٨): إذا كانت العين قيمية فبدلها عند تلفها قيمته، فإن اختلفت باختلاف الاوقات كان على الغاصب قيمة يوم الغصب. هذا إذا كان الاختلاف في القيمة لاختلاف مالية العين المضمونة بسبب عزة وجودها في وقت وكثرته في وقت آخر أو نحو ذلك.
أما إذا كان بسبب اختلاف قيمة النقد الذي يكون التعويض به - كما شاع في عصورنا - فاللازم مراعاة مقدار مالية العين حين الغصب ودفع ما يقابلها من النقد حين التعويض.
(مسألة ١٩): إذاكانت العين مثلية فبدلها عند تلفها مثلها وإن توقف تحصيل الغاصب له على شرائه بأكثر من قيمته وجب عليه ذلك. وإن تعذر عليه تحصيله وجب عليه دفع قيمته حين الدفع.
(مسألة ٢٠): القيمي هو الذي تنسب القيمة فيه لشخصه، فيقال: هذا قيمته كذ، كما في كثير من المصنوعات اليدوية والحيوانات والاشياء المستعملة، والمثلي هو الذي تنسب القيمة فيه لنوعه من دون خصوصية للفرد الخاص، فيقال: هذا النوع قيمته كذ، كما في الذهب والفضة والحبوب والقطن
ومنتوجات المعامل الحديثة ذات الماركات الخاصة. وقد تقدم نظير ذلك في الفصل الخامس من كتاب الاجارة.
(مسألة ٢١): كما يجب على الغاصب دفع بدل العين المغصوبة عند تلفها كذلك يجب عليه دفع بدلها إذا لم تتلف لكن تعذر دفعها لغرق أو سرقة أو ضياع أو نحوه، إذا طالب المالك بالبدل ولم يرض بالانتظار. والأحوط وجوباً له حينئذٍ إن كانت قيمية مراعاة أكثر الامرين من ماليتها يوم الغصب وماليتها يوم الاداء. وحينئذٍ إن دفع البدل ورضي المالك به صارت العين للغاصب، فلو قدر عليها بعد ذلك لم يجب عليه تسليمها للمالك.
(مسألة ٢٢): كما يضمن الغاصب العين المغصوبة يضمن ما استوفاه من منافعه، كما لو سكن الدار أو ركب السيارة أو الدابة أو لبس الثوب أو غير ذلك. إلا في الوقف فقد تقدم عدم ضمان المنافع المستوفاة في بعض أقسامه. فراجع.
(مسألة ٢٣): لا يضمن الغاصب المنافع المستوفاة من قبل غيره، بل يضمنها المستوفي له، سواءً كان استيفاؤه لها بإذن الغاصب أم بدونه. إلا أن يكون المستوفي غير مستقل بالادراك بحيث يكون عرفاً كالالة بيد الغاصب ولا ينسب الاستيفاء له، بل للغاصب، كالطفل غير المميز.
(مسألة ٢٤): لا يضمن الغاصب المنافع غير المستوفاة، كما لو كانت العين المغصوبة ذات منافع لها مالية وقد عطلها الغاصب.
(مسألة ٢٥): إذا تعاقبت الايدي على العين المغصوبة - كما لو باع الغاصب العين على غيره، أو غصبها منه غاصب - وجرت هكذا على أيدي كثيرة كان الكل ضامن، وكان للمالك الرجوع عليهم جميع، كما لو كانت العين لعلي فغصبها منه زيد فصارت منه لعمرو، ومن عمرو لبكر، ومن بكر لخالد، ومن خالد لعباس وهكذ. ويجوز له أيضاً الرجوع على متلف العين بالمباشرة أو
بالتسبيب وإن لم يكن غاصب، لعدم وضع يده على العين. ويأتي الكلام في تحديد المتلف بالمباشرة والتسبيب عند الكلام في أسباب الضمان من كتاب القصاص والديات إن شاء الله تعالى.
(مسألة ٢٦): مع تعاقب الايدي على العين المغصوبة إن رجع المالك على السابق - كزيد في المثال السابق - كان على السابق انتزاع العين ممن بعده ودفعها للمالك، فإن تعذر ذلك أو كانت العين تالفة كان عليه دفع البدل للمالك على ما تقدم.
وأما حكمه مع مَن بعده ممن غصب العين أو أتلفها من دون أن يغصبها فله صور..
الاُولى: أن يكون من بعده قد أخذ العين منه مضمونة عليه بعقد، كما لو كان قد باعها منه. وحينئذٍ يتعين بطلان العقد ورجوع البدل لصاحبه ورجوع الذي ضمن العين للمالك على الشخص المذكور بالعين مع وجوده، وببدلها مع فقده، حتى لو زاد البدل عن البدل الذي تضمنه العقد الباطل، إلا أن يكون ذلك الشخص مغروراً أو مخدوعاً من قبله بأن كان هو يعلم بالحال وأخفاه عليه، فله حينئذٍ أن يرجع بالزيادة عليه، ويقتصر على مقدار الثمن.
الثانية: أن يكون ذلك الشخص قد أخذ العين بدون إذنه. وحينئذٍ يتعين رجوعه عليه بالعين مع وجودها وببدلها مع فقده.
الثالثة: أن يكون ذلك الشخص قد أخذ العين منه مجاناً بنحو غير مضمن، كما لو وهبه إياها أو أودعها عنده. وحينئذٍ يرجع الذي ضمن للمالك عليه بالعين مع وجوده، وفي رجوعه ببدلها مع تلفها إشكال، إلا أن يكون قد أخذها على وجه الامانة وفرط فيه، فيرجع حينئذٍ ببدله.
(مسألة ٢٧): حكم الشخص الذي يضمن للسابق مع من بعده ممن صارت العين عنده أو أتلفها حكم السابق الذي ضمن للمالك معه، فلذلك
الشخص مع ضمانه للسابق الرجوع على من بعده. وهكذا كل من رجع إليه من قبله له أن يرجع على من بعده. ففي المثال السابق إذا رجع زيد بعد الضمان للمالك على عمرو أو بكر كان لعمرو أو بكر الرجوع على خالد مثلاً فإذا ضمن خالد كان له الرجوع على عباس وهكذ، وتجري في اللاحق الصور الثلاث المتقدمة.
(مسألة ٢٨): مع تعاقب الايدي على العين المغصوبة إن رجع المالك على من عدا الاول فدفع له العين مع وجودها وبدلها مع تلفها كان له الرجوع على من بعده - كما تقدم - ولم يكن له الرجوع على من قبله، إلا أن يكون قد أخذها منه بعوض فله الرجوع بالعوض لبطلان المعاوضة. وكذا إذا كان مغروراً مخدوعاً من قبله، فإنه يرجع عليه بما غرم للمالك من قيمة العين والمنافع التي استوفاه. وكذا يرجع بما أنفقه على العين من طعام أو حراسة أو غيرهم. أما لو لم يكن مغروراً من قبله - لجهل المأخوذ منه بالغصبية أو لعلم الاخذ بها وإقدامه معها - فلا يرجع عليه بشيء غير العوض.
(مسألة ٢٩): من أخذ العين المغصوبة من الغاصب - مجاناً أو بعوض ليس له إرجاعها له ولا تبرأ ذمته بذلك، بل لابد من إرجاعها لمالكه، فإن جهل المالك جرى عليها حكم مجهول المالك، الذي أشرنا إليه في مقامات متعددة ويأتي في آخر كتاب اللقطة.
(مسألة ٣٠): لا يجوز شراء المغصوب من الغاصب ولا التصرف فيه إلا بإذن المالك أو من يقوم مقامه - كالوكيل والولي - ولا يسوغ الدخول فيه بغير إذنه صلة للرحم أو لشراء بضاعة لا توجد إلا فيه أو للتداوي أو غير ذلك من موارد الحاجة العرفية، إلا أن يبلغ الامر حدّ الاضطرار المسوّغ للحرام. نعم لا بأس بالدخول في الاراضي المكشوفة غير المسورة وإن كانت مغصوبة.
(مسألة ٣١): يجوز للمالك انتزاع العين المغصوبة من الغاصب، وإذا
امتنع لدعواه استحقاق المغصوب كان له رفعه للحاكم الشرعي، وإذا امتنع من الترافع له كان له انتزاعها منه قهراً عليه وإن استلزم التصرف في ماله - بمثل دخول الدار وفتح القفل - أو الترافع لحاكم الجور بل له التصرف بإتلاف ماله إذا توقف عليه تحصيل العين المغصوبة بمثل كسر القفل ونقب الجدار ووطء الزرع وقتل كلب الحراسة، مع الاقتصار على ما هو الاقل خسارة فالاقل، ولا ضمان حينئذٍ. نعم إذا توقف ذلك على بذل مال من مالك العين المغصوبة أو غيره لم يكن لباذله مطالبة الغاصب به.
(مسألة ٣٢): إذا تعمد الغاصب الغصب فوقع له مال عند مالك العين المغصوبة كان لمالك العين المغصوبة أن يأخذ من ذلك المال بمقدار حقه من باب المقاصة، التي تقدم الكلام فيها وفي شروطها في آخر كتاب الدين، وعليه رد الزائد له. وإذا توقف استيفاء الحق على بيع المال الذي وقع في يد المغصوب منه فالأحوط وجوباً استئذان الحاكم الشرعي فيه.
والحمد لله رب العالمين
كتاب إحياء الموات
الأرض على قسمين..
الأول: الارض العامرة ببناء أو زرع، فإن كانت مملوكة لشخص بالاحياء أو الشراء فهو، وإن لم تكن مملوكة - كالغابات - فهي تملك بالسبق إليها وحيازتها بقصد التملك، كسائر المباحات الاصلية.
الثاني: الأرض الميتة، وهي الخالية من البناء والزرع. وهي محل الكلام في المقام.
(مسألة ١): يجوز إحياء الارض الميتة بالاصل ويجري عليها بالاحياء حكم الملك سواءً كان المحيي لها مسلماً - مؤمناً أو مخالفاً - أم كافر.
(مسألة ٢): لا تملك الارض الميتة بغير الاحياء كالتسجيل في الطابو هبة من الدولة أو شراء منه، بل تبقى على إباحتها الاصلية، فيجوز لكل أحد تملكها بالاحياء وليس لمن سجلت الارض باسمه حق منعه منه، فضلاً عن إزالة بنائها ونحوه مما يتحقق به الاحياء، نعم لا يجب عليه أن يتنازل للمحيي في دائرة الطابو، بل له الامتناع منه وأخذ مال في مقابله. وعلى ذلك لا يجوز لمن سجلت الارض باسمه من دون إحياء بيع الارض ما دامت ميتة، إذ لابد في المبيع من كونه مملوكاً للبائع. نعم له أن يأخذ المال في مقابل التنازل لدافعه في دائرة الطابو.
(مسألة ٣): الارض المملوكة إذا ترك المالك عمارتها حتى خربت جاز لغيره عمارته، سواء لم يكن لها مالك عرفاً - كأراضي الاُمم السالفة التي لا بقية لها معروفة - أم كان لها مالك معلوم أو مجهول، وسواء كان المالك الاول قد تملكها بالاحياء أم بغيره، كالارث والشراء ونحوهم، وسواء كان الترك للاعراض عن نفس الارض أو عن عمارتها أم للعجز عن العمارة أم لدواع اُخر، كالانشغال بما هو أهم. نعم لابد من مضي مدة معتد به، بحيث يصدق بأنه أخربه.
(مسألة ٤): إذا كان ترك المالك عمارتها حتى خربت بسبب منع ظالم من عمارتها فالظاهر عدم جواز إحيائها بغير إذن المالك. إلا أن يستمر الخراب بعد ارتفاع المنع، بحيث يصير بوسعه أن يحييه، فيترك إحياءه، فيجوز حينئذٍ لغيره إحياؤه. وأولى بالجواز ما إذا صار ذلك سبباً في الاعراض عن الارض.
(مسألة ٥): الأحوط وجوباً عدم مزاحمة المالك الاول إذا أراد السبق لاحياء الارض التي تركها حتى خربت، فلا يسابقه غيره في الاحياء. نعم إذا أحياها غيره فليس له المطالبة بها ليحييها هو، بل الحق للثاني وحده.
(مسألة ٦): الأحوط وجوباً عدم إحياء الارض إذا كان عدم إحياء المالك الاول لحاجة له في الارض غير الاحياء، كما لو أراد أن ينتفع بحشيشها أو قصبها أو يجعلها مرعى لانعامه أو نحو ذلك مما لا يصدق معه أنه ترك الارض.
(مسألة ٧): ما في الارض الخربة من الاخشاب والاحجار والحديد واُصول الشجر وغير ذلك إن اُحرز إعراض مالكه عنه جاز تملكه، وكذا إذا كان تابعاً لارض خربة قد باد أهلها أو انجلوا عنه. وفي غير ذلك لا يجوز تملكه، بل لابد من مراجعة مالكه مع معرفته والفحص عنه مع الجهل به، ومع اليأس من العثور عليه يجري عليه حكم مجهول المالك الذي يأتي في آخر كتاب اللقطة.
(مسألة ٨): الاوقاف إن كانت في القرى القديمة التي خربت وباد أهله
أو انجلوا عنها تملك بالاحياء. أما في غير ذلك فهي باقية على الوقفية، ومع الجهل بوجه الوقفية يجري ما تقدم في كتاب الوقف.
(مسألة ٩): يشكل ملكية الارض بالاحياء إذا كان الاحياء لا بقصد حيازة الارض وتملكه، بل كان لمجرد قضاء وطر منه، كما لو زرع الخارج للنزهة أيام الربيع في الارض زرعاً ليأكل منه في وقت نزهته، أو بنى فيها بناء لينتفع به موقت. نعم لا إشكال في تملكه لها بعد الاحياء بمجرد الحيازة بقصد التملك، نظير ما تقدم في الغابات.
(مسألة ١٠): لا يشترط في حصول الملك بالاحياء المباشرة، بل يكفي التوكيل فيه، فإذا أحيى الوكيل الارض للموكل مجاناً أو بثمن ملكها الموكل. وكذا الحال للولي بالاضافة للمولى عليه، نعم في كفاية التبرع عن الغير في الاحياء ابتداءً من دون توكيل في ملكية المتبرع عنه إشكال، بل منع. وحينئذٍ يشكل ملكية المحيي لها أيض، لانه لم يقصد التملك، كما يظهر مما تقدم.
(مسألة ١١): إحياء الارض عبارة عن فعل ما يصدق معه إعمارها عرفاً كجعلها مزرعة أو داراً أو محلاً تجارياً أو مخزناً للحبوب أو حظيرة للحيوانات أو غير ذلك، ومع عدم حصول شيء من ذلك لا إحياء. نعم قد يتحقق التحجير الذي يأتي الكلام فيه.
(مسألة ١٢): من ملك أرضاً بالاحياء أو غيره يثبت له الحق في حريمها كالطريق والنهر والمرعى ونحو ذلك مما يتوقف عليه الانتفاع بها بالوجه المعدة له على ما يأتي تحديده، فلا يجوز لغيره تملكه بالاحياء ولا بالتصرف تصرفاً ينافي الوجه المطلوب من الحريم.
(مسألة ١٣): حد الطريق المبتكر مع التشاح خمسة أذرع - تقارب المترين ونصفاً - ويستحب سبعة أذرع - تقارب الثلاثة أمتار ونصفاً - بمعنى: أن من
كانت له أرض، وأراد الآخر أن يحيي أرضاً في الجهة المقابلة فلابد أن يتباعد عنه من أجل فسح المجال بالمقدار المذكور. وكذا إذا أحيى أرضاً تبعد عن الطريق العام فإن له الطريق إليها بالمقدار المذكور. أما إذا اتفقوا على الاكثر أو الاقل فلهم ذلك، إلا أن يكون مضراً بالمارة فلابد من سعة الطريق بما يناسبهم.
(مسألة ١٤): إذا اتفق الطرفان عند إحياء الجانبين على جعل الطريق دون الحد ولم يكن مضراً بالمارة، ثم بعد ذلك كثر المارة واحتاجوا لسعة الطريق لم يجب على الطرفين توسيعه من ملكهم. كما أنه إذا اتفق الطرفان على جعل الطريق أكثر من الحد وجرى عليه المارة مدة من الزمان لم يكن لاحد الطرفين أو كليهما تضييقه وإن لم يضر بالمارة
(مسألة ١٥): إذا كان الطريق مطروقاً بمرور القوافل أو السيارات في الارض الموات قبل إحياء جانبيه لا يجوز تضييقه بإحياء جانبيه مهما كان واسع، والحد المتقدم إنما هو للطريق المبتكر عند إحياء الجانبين.
(مسألة ١٦): حريم البئر التي تحفر في الموات لسقي الابل ونحوها أربعون ذراعاً - تقارب العشرين متراً - من جوانبها الاربعة، ليكون ذلك المكان مجمعاً للابل حين السقي. أما إذا حفرت لسقي الزرع فحريمها ستون ذراعاً تقارب الثلاثين متراً - من جوانبها الاربعة ليكون ذلك مجمعاً للحيوانات التي تنقل الماء لسقي الزرع.
(مسألة ١٧): لا يجوز لأحد أن يحفر بئراً تضر ببئر سابقة على بئره لغيره، ولا عيناً تضر بعين سابقة لغيره إذا كان الضرر معتداً به.
(مسألة ١٨): حريم النهر العام والمستحدث لشخص خاص الموضع الذي يجعل فيه ترابه عند حفره وتنظيفه والطريق الذي يعبر عليه المارة من جانبيه.
(مسألة ١٩): حريم الدار الطريق إليها من جهة بابه، بالمقدار المتقدم في تحديد الطريق. وأما ما زاد عليه مما قد يحتاج إليه لالقاء القمامة ونحوها فالظاهر عدم ثبوت الحريم فيه، إلا أن يتخذ صاحب الدار مكاناً لذلك ويستغله مدة من الزمن ففي جواز مزاحمته حينئذٍ في ذلك المكان إشكال.
(مسألة ٢٠): ما يخصص في بعض البلاد من المواضع العامة كالمنتزهات والساحات والمراعي والبيادر والغابات والمقابر - لا يتعين بمجرد تعيين الموضع رسمياً أو باتفاق أهل البلد، بل لابد مع ذلك من استغلالهم له فيما اُعد له وجريهم على ذلك مدة معتداً به.
(مسألة ٢١): كما يملك الانسان الارض بالاحياء ويـثبت له الحق في حريمه، كذلك يثبت له الحق فيها وفي حريمها بالتحجير مقدمة للاحياء، كتحديد الحدود وحفر الاُسس مقدمة لبنائها بل وكذا بناء الاُسس إذا لم يبلغ مرتبة يتحقق به الاحياء عرف، فإن ذلك يوجب الحق في الارض وفي الحريم المناسب لما يراد بالاحياء، وأمد الحق المذكور هو الزمن الذي يتعارف بين التحجير بالوجه الحاصل والاحياء، فإن طالت المدة سقط حق التحجير، وكان للغير المبادرة للاحياء. نعم إذا كان التحجير بشيء مملوك للمحجر، كبناء الاُسس أشكل التصرف فيه ما لم يثبت إعراضه عنه وكذا اذا صدق عرفاً تعطيله للارض.لكن الأحوط وجوباً حينئذٍ مراجعة الحاكم الشرعي. نعم لو تصرف فيه من دون ذلك فأزاله كان ضامناً وصح منه الاحياء وملك الارض به.
(مسألة ٢٢): من حفر بئراً أو استنبط عيناً أو شق نهراً للزرع ثبت له حق التحجير في الارض التي من شأنها أن تزرع بتلك البئر أو العين أو ذلك النهر، بل يثبت له الحق بالشروع في حفر البئر أو استنباط العين أو حفر النهرعلى النحو المتقدم في المسألة السابقة.
(مسألة ٢٣): التحجير وإن لم يوجب ملكية الارض المحجورة - فلا يجوز بيعها - إلا أنه يوجب حقاً فيها يمكن المصالحة عليه بعوض.
(مسألة ٢٤): لا أثر لتحجير ما لا يراد إحياؤه أو ما يعجز المحجر عن إحيائه، فلا يثبت به حق مانع من إحياء غيره، ليمكن المصالحة عليه بعوض. نعم يجري في المواد التي يحجر بها - من بناء أو نحوه - ما تقدم في المسألة(٢١).
(مسألة ٢٥): من بنى حائطاً حول قطعة من الارض، فإن عدّ ذلك إحياء لهاملكه، كما لو جعلها حظيرة للحيوانات أو موضعاً لجمع الحبوب أو نحو ذلك، وإلا كان محجراً لها وجرى حكم التحجير المتقدم، كما لو بناه مثلاً من جوانبها الاربعة من دون باب يفضي منه للخارج.
(مسألة ٢٦): الاراضي المنسوبة للقبائل لمجاورتها لمساكنهم إذا لم تكن مملوكة لهم بالاحياء فإن كانت مخصصة منهم للانتفاع بها بمثل الرعي والنزهة ونحوهما كانت من حريم أملاكهم، نظير ما تقدم في المسألة (٢٠) ولا يسوغ لغيرهم إحياؤها ومزاحمتهم فيه، بل لا يجوز ذلك لبعضهم من دون رضا الباقين، وإن لم تكن مخصصة منهم لذلك فلا حق لهم فيها وجاز لبعضهم ولغيرهم الانتفاع به، وتملكها بالاحياء من دون إذنهم، ويحرم عليهم المنع من ذلك أو أخذ العوض عليه. كما أنها لو قسمت بينهم بالتراضي من دون إحياء فلا أثر للقسمة، فهي نظير الصحاري المجاورة للمدن التي يجوز لكل أحد إحياؤه، وبه تتسع المدن.
(مسألة ٢٧): المواضع العامة التابعة للمدن - كالطرق والساحات والمنتزهات - إن صارت من الموات عرفاً جاز لكل أحد إحياؤها وتملكه، كما لو ماتت تبعاً لموت المدينة أو المحلة التابعة له، وكما لو هجر المنتزه أو الطريق حتى صار مزبلة أو مستنقع. وإن لم تصر من الموات عرفاً فمع احتياج الناس
إليها لا يجوز مزاحمتهم فيها إلا مع الضرورة فلابد من مراجعة الحاكم الشرعي لتشخيص مرتبة الضرورة التي يقطع معها برضا الشارع الاقدس بالتصرف. ومع استغناء الناس عنها يجوز الاستيلاء عليها وأخذها بالعوض أو جعلها لمنفعة عامة بدلاً عما كانت عليه. وكل ذلك بإذن الحاكم الشرعي.
(مسألة ٢٨): يحرم على الانسان أن يتصرف في ملكه تصرفاً يسري إلى ملك جاره بنحو يضر به ضرراً لا يتعارف بين الجيران، كما لو أجرى الماء بنحو يسري هو أو رطوبته لحائط الجار فيضر به، سواءً كان ترك التصرف المذكور مضراً به أم لم يكن، ولو فعل كان ضامناً لما يحدثه من الضرر. أما إذا كان التصرف مضراً بالجار من دون أن يسري إلى ملك الجار، كما إذا رفع حائطه فمنع الهواء أو الشمس عنه فهو جائز، إلا أن يكون ضرر الجار كثيراً جداً ففي الجواز إشكال. هذا في غير البئر والعين، أما فيهما فلا يجوز الاضرار، كما تقدم في المسألة (١٧).
(مسألة ٢٩): قد حث الشارع الأقدس على حسن الجوار والاحسان للجار، ففي وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «والله الله في جيرانكم، فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم»، وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «الجار كالنفس... وحرمة الجار على الجار كحرمة اُمه». وقد استفاضت الاخبار بأن حسن الجوار معمر الديار ويزيد في الرزق والاعمار. كما أكد الشارع الاقدس أيضاً في الزجر عن أذى الجار، ففي الحديث عن الامام الصادق (عليه السلام): «من كف أذاه عن جاره أقاله الله عثرته يوم القيامة»، وفي حديث آخر: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره»، وفي حديث ثالث: «من آذى جاره حرَّم الله عليه الجنة، ومأواه جهنم وبئس المصير، ومن ضيَّع حقَّ جاره فليس من».
(مسألة ٣٠): يستحب للانسان أن يعين جاره - بل كل مؤمن - فيما يقدر
عليه، ومن ذلك إعانته في مسكنه إن احتاج إلى شيء منه.
(مسألة ٣١): إذا أذن الجار لجاره بالتصرف في منزله واستغلاله، كما إذا أذن له في أن يضع فرسه في حظيرته، أو يضع سقف غرفته على حائطه، أو يجري ماءه في بالوعته فلذلك صورتان..
الاُولى: أن يرجع إلى تعهد الآذن باستحقاق الجار للأمر المأذون فيه على تقدير فعل المقدمة من قبله ويفعل الجار المقدمة بناء على التعهد المذكور فيكون مرجع الإذن في الاُمور المتقدمة مثلاً إلى تعهد الآذن لجاره بأنه إن اشترى فرساً كان له أن يضعه في حظيرته، وإن أقام بقية حيطان الغرفة وهيأ السقف كان له أن يضعه على حائطه، وإن شق المجرى للبالوعة كان له أن يجري ماءه فيه حتى يستقر فيه، ويفعل الجار المقدمات المذكورة اعتماداً على التعهد المذكور، وحينئذٍ لا يجوز للآذن العدول عن إذنه ولا يترتب الأثر على عدوله بعد فعل المقدمات المذكورة قبل فعل الأمر المأذون فيه، فضلاً عما لو باشر بفعله.
الثانية: أن لا يرجع الآذن إلى التعهد بالنحو المذكور، وحينئذٍ إن كان الأمر المأذون فيه مبنياً على التكرار - كوضع الفرس في الحظيرة وإجراء الماء في البالوعة - كان للآذن العدول عن الإذن بعد الشروع في العمل المأذون فيه فضلاً عما قبله. وإن لم يكن الأمر المأذون فيه مبنياً على التكرار، بل كان من شأنه البقاء بنفسه - كوضع سقف الغرفة على حائطه - فلا إشكال في أن له العدول عن الإذن قبل فعل الأمر المأذون فيه، وكذا بعده إذا لم يبتن الإذن على استمرار الأمر المأذون فيه، بل على فعله موقت، فله أن يأمره حينئذٍ برفع سقف الغرفة مثلاً متى شاء، سواء أضر ذلك بالجار أم ل. وأما إذا ابتنى الإذن على استمرار الأمر المأذون فيه فإنما يجوز العدول عن الإذن إذا لم يكن العدول عن التصرف مضراً بالجار، أما مع إضراره به فلا يجوز، كما لو كان رفع السقف مثلاً موجب
لتلف البناء أو نقصه على الجار. إلا أن يتدارك الاذن الضرر الحاصل، فيجوز له حينئذٍ العدول. ويجري هذا التفصيل في كل من أذن لغيره بالتصرف في ملكه، ولا يختص بالجار مع جاره.
(مسألة ٣٢): إعراض المالك عن ملكه لا يوجب زوال ملكيته له، بل هو راجع للرضا بتملك غيره له، فمن سبق إلى تملكه ملكه منه. فإن خرج المالك الاول عن السلطنة - بموت أو جنون أو غيرهما - قبل تملك الغير بقي على ملكه ولم يجز تملكه. نعم لو شك في عروض ذلك كان للغير البناء على عدمه، فله تملكه.
تتميم: في المشتركات
وهي اُمور..
الأول: الاوقاف للجهات العامة أوالخاصة، والاشتراك فيها تابع لكيفية وقفه، وقد تقدم في آخر الفصل السابع من كتاب الوقف حكم تشاح الموقوف عليهم في الانتفاع به.
الثاني: المساجد والمشاهد المعدة للزوار. وقد سبق في مبحث مكان المصلي من كتاب الصلاة حكم السبق إلى مكان فيها وفروع ذلك. نعم الظاهر استمرار حق الاختصاص إلى الليل وعدم الاستمرار إلى اليوم الثاني، حتى لو أبقى متاعه فيه. إلا أن يبقى بنفسه فيه أو يسبق إليه في اليوم الثاني فيتجدد له الحق فيه.
(مسألة ٣٣): يجوز لكل مسلم إشغال المسجد بالصلاة وسائر العبادات والتدريس وغيره حتى النوم والبيع والشراء، إلا ما كان على نحو تهتك به حرمة المسجد. ومن سبق إلى مكان فيه فهو أحق به كما أشرنا إليه آنف. نعم الظاهر
تقدم الصلاة فيه على غيره. والمتيقن منه الصلاة في أوقات الفرائض جماعة بالوضع المتعارف عليه في ذلك المسجد، فلا يجوز مزاحمته. بل الأحوط وجوباً ذلك في الصلاة فرادى عند دخول الوقت، أما بعد ذلك فالظاهر عدم الاولوية للصلاة، إذا أمكن الإتيان بها في موضع آخر من المسجد.
(مسألة ٣٤): يجوز إشغال المشاهد المشرفة بما يجوز به إشغال المساجد، نعم الظاهر تقدم العبادات - من الصلاة وقراءة القرآن وغيرهماووظائف الزيارة على غيره، فلا يجوز مزاحمة غيرها له. والظاهر عدم تقديم وظائف الزيارة على غيرها من أنواع العبادة عند التزاحم. نعم الظاهر عدم جواز المزاحمة بنحو يقتضي تعطيل المشهد عن وظائف الزيارة بالمقدار المعتد به، إلا عند دخول وقت الصلاة فلا مانع من إشغال المشهد بها مع سبق المصلين وإن استلزم التعطيل عن وظائف الزيارة.
الثالث: الاسواق. والمراد بها الساحات الواسعة التي لا تختص بشخص أو جهة والتي تبانى الناس على عرض بضائعهم فيها للبيع والشراء على نحو العموم. ويجري في السبق إليها ما يجري في المساجد والمشاهد.
الرابع: الطرق. وهي على قسمين..
الأول: الطرق غير النافذة وهي المحاطة بالبناء من جوانبها الثلاثة.
الثاني: الطرق النافذة وهي المحاطة بالبناء من جانبين فقط.
(مسألة ٣٥): الطريق غير النافذ - وهو المسمى في عرفنا بالدريبة مختص بمن له باب مفتوح فيه وهو مشترك بينهم. نعم لا يحتاج تصرف كل منهم فيه بالعبور والجلوس وغير ذلك إلى استئذان الآخرين حتى لو كان فيهم قاصر. بل الظاهر أنه يجوز لبعضهم أن يوسع بابه أو يفتح باباً اُخرى أو نافذة إلى الطريق المذكور من دون إذنهم. إلا أن يكون التصرف بذلك أو غيره مضراً ببعضهم
فلابد من استئذانهم. وكذا إذا وقع الاتفاق بينهم والتصالح على أن لكل منهم نحواً خاصاً من التصرف، فإنه لا يجوز لاحدهم الخروج عنه إلا بإذن الباقين.
(مسألة ٣٦): لا يجوز إخراج الاجنحة الشاغلة للفضاء وحفر السراديب والبلاليع الشاغلة للباطن و نصب الميازيب في الطريق غير النافذ إذا كان مملوكاً بالاصل لاصحاب الدور التي فيه فاتفقوا على جعله طريقاً بينهم، إلا أن يأذنوا في ذلك. وأما إذا لم يكن مملوكاً لهم وإنما صار طريقاً بسبب إحيائهم لجوانبه فالظاهر جواز الجميع من دون إذن، إلا مع الاضرار بالمارة ومزاحمته للعبور لكون الجناح منخفضاً مثلاً فلا يجوز. بل لو كان مضراً بالطريق عرفاً من دون أن يزاحم العبور ففي جوازه إشكال، كما لو كان موجباً لظلام الطريق أو حبس الهواء عنه.
(مسألة ٣٧): إذا كان الطريق غير النافذ محجوباً بباب أو نحوه لم يحل لغير أهله التصرف فيه بالمرور أو الجلوس أو غيرهما إلا بإذنهم، وإن لم يكن محجوباً جاز التصرف فيه بغير إذنهم تصرفاً لا يضرّ بهم.
(مسألة ٣٨): من كان لملكه حائط مسدود في الطريق غير النافذ ليس له أن يفتح باباً له إلا بإذن أربابه وهم أصحاب الابواب المفتوحة فيه.
(مسألة ٣٩): إذا ألغى أحد أصحاب الطريق غير النافذ بابه لم يسقط حقه فيه إلا أن يصالحه بقية أرباب الطريق عن حقه، بحيث يتنازل لهم عنه ويجعله لهم.
(مسألة ٤٠): الطريق النافذ من المشتركات العامة التي لا يختص بها أحد، فيجوز لكل أحد التصرف فيه بالعبور والجلوس والنوم والبيع والشراء وغيره. ولا يجوز لاحد منعه ومزاحمته من قضاء وطره. نعم لابد في جميع ذلك من أن لا يضر بالمارة، وإلا كان معتدياً ضامناً لما يحدث من ضرر عليهم بسببه.
(مسألة ٤١): من سبق إلى مكان في الطريق كان أحق به ما دام فيه، وكذا إذا قام عنه وأشغله برحله ومتاعه، فإنه لا يجوز لغيره التصرف فيه مهما طال
الزمان. نعم إذا لم يشغله بشيء سقط حقه وجاز لغيره إشغاله، سواء كان حين قيامه ناوياً للعود أم ل.
(مسألة ٤٢): يجوز التصرف في الطريق النافذ - بإنشاء الابواب والنوافذ عليه وإخراج الاجنحة ونصب الميازيب وحفر البلاليع والسراديب ونحو ذلك ما لم يضر بالمارة بنحو يزاحم العبور،بل الأحوط وجوباًالترك إذاكان مضراً بالطريق عرفاً من دون أن يزاحم العبور. كما لو كان موجباً لظلامه أو حبس الهواء عنه. نظير ما تقدم في الطريق غير النافذ.
الخامس: مياه البحار والشطوط والانهار الكبار والصغار التي جرت من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج. وكذا مياه العيون التي تفجرت بنفسها ومياه الغدران والمستنقعات في الارض الموات.
(مسألة ٤٣): المياه المشتركة من المباحات الاصلية لا يجوز لاحد منع الناس عنه، كما لا يجوز لبعضهم بيعها قبل حيازتها وتملكه. نعم يجوز لبعضهم مصالحة الآخرين على عدم استغلاله الماء في مقابل عوض يدفعه له.
(مسألة ٤٤): من سبق إلى شيء من المياه المشتركة كان أحق بالانتفاع به بالسقي وغيره، ومن حاز شيئاً منه ملكه.
(مسألة ٤٥): من شق نهراً من المياه المشتركة في أرضه أو في أرض موات بقصد الحيازة لمائه ملك ماءه ولا يجوز لاحد مزاحمته فيه.
(مسألة ٤٦): من فجر عيناً أو حفر بئراً في أرض موات بقصد الحيازة لمائها كان الماء له، وكذا إذا تفجرت العين أو حفرت البئر في ملكه وإن لم تكن بقصد الحيازة.
(مسألة ٤٧): إذا حفر غاصب الارض بئراً فيها أو فجر عيناً فيها كان ماؤها لصاحب الارض المغصوبة فلا يجوز التصرف فيه بغير إذنه، ولا يكفي إذن
الغاصب. نعم إذا جرى الماء بنفسه أو بفعل الغاصب فسقى بنفسه أرض الغير من دون أن يستولي عليه صاحب الارض ولا يستند جريانه في متعرجات الارض إليه لم يكن على صاحب الارض إثم ولا ضمان، بل يكون ذلك على الغاصب وحده.
(مسألة ٤٨): من صنع على حافة الماء المشترك - الذي تقدم أنه من المباحات الاصلية - مسناة أو نحوها مما يتيسر معه الاستقاء من الماء كان أولى به، ولا يجوز لغيره مزاحمته فيها ويجوز له التنازل عنها لغيره، بل يجوز له المصالحة عن حقه فيها بعوض على كراهة. وليس له بيع الماء بنفسه لعدم كونه مملوكاً له. وهذا بخلاف ما إذا كان الماء مختصاً بشخص واحد أو أشخاص خاصين، فإنه يجوز لصاحب الماء أن يبيع لغيره الماء بنفسه، وكذا يجوز للشريك بيع حصته منه.
(مسألة ٤٩): المياه الخاصة إن كانت في أرض محجوبة لم يحل التصرف فيها بالشرب والغسل ونحوهما بغير إذن مالكه. أما إذا كانت في أرض مكشوفة فإنه يجوز التصرف فيها بذلك للعابرين والواردين من غير حاجة لاذن المالك ما لم يضروا بالماء. نعم لا يجوز سقي الزرع به ولا خزن مقدار كثير منه، ونحوه من الاستعمالات المهمة المقصودة من المياه المذكورة إلا بإذن المالك.
(مسألة ٥٠): من نصب على نهر غيره رحىً أو غرس عليه أشجاراً فإن لم يكن بإذن صاحب النهر لم يمنع ذلك صاحب النهر من نقل النهر أو تحويل مجراه أو تغويره وإماتته. وكذا إذا كان بإذنه، إلا أن يرجع إذنه في ذلك إلى تعهده بإبقاء النهر لصلاح ذلك الشيء الذي أذن فيه على تقدير إحداثه ويكون إحداثه من قبل صاحبه مبنياً على التعهد المذكور.
(مسألة ٥١): إذا اجتمع جماعة على ماء مباح من أجل استغلاله والانتفاع به لم يكن لبعضهم الاستئثار به ومنع الآخرين منه، ولو بتحويل مجراه لصالحه وحده. وحينئذٍ إن كفاهم فلا إشكال، وإن لم يكفهم فلذلك صورتان..
الاُولى: أن يتعاقبوا على الماء بأن يكون بعضهم أسبق من بعض، كما إذا أحيى جماعة على التعاقب الاراضي المحيطة بالماء لزراعتها مثل، وحينئذٍ يكون الحق للاسبق فالاسبق في أخذ مقدار حاجته لسقي الارض التي سبق منه إحياؤه. أما الارض التي يريد إحياءها لاحقاً بعد إحياء غيره فلا يكون له الحق في أخذ ما تحتاج إليه إلا بعد أن تكتفي الاراضي المحياة قبلها من قبل غيره. فإذا أحيى زيد دونماً من الارض ثم أحيى عمرو دونماً ثم أحيى بكر دونم، ثم أراد زيد أن يحيي دونماً آخر، كان زيد مقدماً على الباقين في سقي دونمه الاول، وليس له سقي دونمه الآخر إلا بعد اكتفاء دونم عمرو ودونم بكر.
هذا كله مع شحة الماء من أول الامر، وأما لو كان وافياً بحاجتهم من أول الامر ثم شح بعد ذلك ففي ترجيح الاسبق منهم إشكال.
الثانية: أن يجتمعوا على الماء دفعة واحدة وحينئذٍ لا ترجيح لبعضهم، بل يجب عليهم تقاسم الماء بالسوية ويقتصر كل منهم على سهمه منه. نعم في الصورتين معاً لو صالح بعضهم بعضاً على التنازل عن حقه من الماء بعوض كان له حقه منه.
(مسألة ٥٢): مع شحة الماء واحتياج المتشاحين لقسمته، فقسمته بأحد وجهين..
الأول: قسمته بالاجزاء بأن يستقي كل منهم مقداراً من الدلاء أو يفتح كل منهم نهراً ضيقاً بمقدار حصته من الماء.
الثاني: المهاياة بأن يتفقوا بينهم على أن لكل منهم على التعاقب أن يستقل بالماء كله مدة معينة، كساعة أو يوم أو اسبوع. والوجه الاول هو الاصل، ولا ينفذ عليهم الثاني إلا برضاهم، فإن اتفقوا عليه إلى مدة معينة لزمهم العمل عليه في تلك المدة، ولا يجوز لبعضهم الخروج عنه إلا برضا الباقين. وإن اتفقوا مؤقتاً
من دون تحديد مدة كان لهم العدول عنه إلى الاول. نعم لا يجوز لمن استوفى نوبته العدول عنه إلا بعد استيفاء الباقين لنوبتهم.
ولا يفرق في الوجهين بين الماء المشترك بنحو العموم الذي يتشاح عليه المستفيدون منه والماء المملوك المشترك بين جماعة خاصين.
(مسألة ٥٣): تنقية النهر المشترك بين جماعة خاصين عليهم كلهم إن أرادوا ذلك، وإن اختلفوا فإن كانت التنقية ضرورية للنهر بأن كان ينقص نقصاً معتداً به بدونها اُلزم المخالف بالاشتراك في نفقة التنقية أو ببيع حصته من النهر أو نحو ذلك مما يجمع بين الحقوق، ولو بالرجوع للحاكم الشرعي مع التشاح والتخاصم - نظير سائر موارد الشركة - لو احتاج الامر المشترك للنفقة. وإن لم تكن التنقية ضرورية، بل كانت فائدتها تحسين النهر لا غير لم يلزم المخالف بشيء. وفي كلا الحالين لو أقدم بعضهم على التنقية من دون مراجعة الآخرين تحمل هو نفقتها كاملاً وليس له إلزام الآخرين بدفع ما يناسب حصتهم منه. إلا أن يكون مفوضاً من قبلهم.
السادس: المراعي في الارض الموات غير مملوكة لاحد. فلكل أحد الانتفاع بها وليس لاحد أن يحميها ويمنع غيره منه. أما المراعي في الارض المملوكة لو اتخذها مالكها مرعىً لانعامه فهي تختص به وليس لاحد الرعي فيها إلا بإذنه.
السابع: ما في الارض الموات غير المملوكة لاحد من المعادن وغيرها كالحصى والرمل والحجر والحطب وغيره، فلكل واحد ما سبق إليه منها ولا يجوز لاحد أن يحميها ويمنع غيره منه. نعم يثبت في المعدن الخمس بالشروط المتقدمة في كتاب الخمس.
والحمد لله رب العالمين
كتاب اللقطة
المراد باللقطة هنا كل ضائع عمن يختص به. وهو إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الاموال. والاول يسمى لقيط، والثاني يمسى ضالة، والثالث يسمى لقطة بالمعنى الاخص، وإليه ينصرف إطلاق لفظ اللقطة. فيقع الكلام في فصول ثلاثة.
الفصل الأول
في اللقيط
وهو الطفل الضائع الذي لا يعرف أهله، سواء علم بأنه منبوذ من أهله قد تعمدوا تركه لعجز عن تربيته أو لخوف العار والفضيحة أو لغير ذلك، أم علم بأنه قد ضاع على أهله أو نهب منهم ثم نبذ، أم علم بأن أهله قد هلكوا من دون أن يعرفوا فبقي وحده، أم جهل حاله. وهو محكوم بالحرية، إلا أن يعلم برقيته، فيلحقه حكم الضالة الاتي.
(مسألة ١): يجب التقاط الطفل الضائع، إذا خيف عليه التلف لولا الالتقاط، وكان محكوماً عليه بأنه محترم الدم، كما لو علم بأنه من مسلم أو ذمي، أو كان في بلد يغلب عليه المسلمون أو أهل الذمة أو هما مع. أما لو لم يخش عليه التلف فلا يجب التقاطه، ولو لم يحكم بأنه محترم الدم وخشي عليه التلف ففي
جواز تضييعه وعدم التقاطه إشكال.
(مسألة ٢): إذا التقط الطفل الضائع ملتقط كانت ولايته له، فيجب عليه رعايته وحضانته إلى أن يجد أهله أو من له الولاية عليه فيدفعه إليهم. ويجب عليه الفحص عنهم بالنحو المتعارف حتى يتحقق اليأس من العثور عليهم. إلا أن يعلم بكونه منبوذاً من قبلهم قد أعرضوا عن القيام فيه بمقتضى ولايتهم عليه.
(مسألة ٣): إنما تثبت الولاية للملتقط إذا كان بالغاً عاقلاً حر، فلا أثر لالتقاط الصبي والمجنون ولا لالتقاط العبد إلا إذا كان بإذن مولاه.
(مسألة ٤): إذا كان اللقيط محكوماً بالاسلام - كما إذا علم بإسلام أحد أبويه أو كان في بلد يغلب عليه المسلمون - فلابد في ولاية الملتقط عليه من أن يكون مسلم، وإلا وجب عليه حفظه وتكون ولايته للمسلمين. والأحوط وجوباً مراجعة الحاكم الشرعي في أمره.
(مسألة ٥): إذا كان مع اللقيط مال حكم بأنه ملك له، لكن كثيراً ما تقوم القرينة على خلاف ذلك، مثل كون المال مجعولاً معه ممن ينبذه ويتركه لأجل أن ينفقه عليه الملتقط، أو كون المال لغيره قد تركه قسراً عليه، كالطفل الذي ضاع من أهله ومعه مال لهم لا يناسب كونه ملكاً له. ويجري على الاول حكم المال المأذون في إنفاقه عليه، وعلى الثاني حكم مجهول المالك.
(مسألة ٦): إذا وجد متبرع ينفق على اللقيط أنفق عليه، ومنه ما إذا كان معه مال قامت القرينة على إذن صاحبه في إنفاقه عليه، كما أشرنا إليه في المسألة السابقة، وكذا إذا تهيأ الانفاق عليه من الاموال المعدة للفقراء كالحقوق الشرعية ونحوها إذا كان مصرفاً له. ومع عدم الامرين فإن كان له مال أنفق عليه منه، وكذا إن أمكن اكتسابه بعمله وتعيشه من كسبه. ومع تعذر ذلك أيضاً ينفق عليه الملتقط من ماله، وحينئذٍ إن أنفق عليه بقصد التبرع المحض فلا رجوع، وإن لم يقصد التبرع حين الانفاق، بل كان الانفاق بقصد الرجوع
كان له الرجوع عليه إذا كبر إن كان له مال، وإن لم يكن له مال فلا رجوع، بل يحسب له ما أنفقه صدقة.
(مسألة ٧): إذا أنفق الملتقط من ماله على اللقيط برجاء أن يكون ولاؤه له لم يلزم ذلك اللقيط، بل له أن يوال - بعد أن يكبر - من يشاء. وحينئذٍ فإن والى الملتقط لم يرجع الملتقط عليه بما أنفق حتى لو كان اللقيط موسر. وإن والى غيره وجب عليه مع يساره أن يؤدي للملتقط ما أنفقه، وإن لم يكن موسراً لم يجب عليه شيء، وحسب للملتقط ما أنفقه صدقة. والظاهر عدم وجوب مراجعة الحاكم الشرعي في جميع ذلك، بل ينفذ تصرف الملتقط مع مراعاته لمصلحة اللقيط.
(مسألة ٨): اللقيط إن عرف أهله فذاك، وإلا كان ميراثه للامام (عليه السلام) وعليه ضمان جريرته. إلا أن يكبر فيوالي الملتقط أو غيره، فيكون ميراثه لمن يواليه وجريرته عليه.
(مسألة ٩): المراد بالولاء أن يوالي شخصاً آخر على أن يضمن جريرته، بأن يتحمل عنه دية الخط. ويأتي توضيح ذلك في كتاب الميراث إن شاء الله تعالى.
(مسألة ١٠): لا يجوز للملتقط تبني اللقيط بحيث ينتسب له، ولا يترتب الاثر على التبني المذكور ولو حصل، كما هو الحال في غير اللقيط على ما سبق التعرض لذلك في فصل أحكام الاولاد من كتاب النكاح.
(مسألة ١١): إذا كان الضائع كبيراً لا يستقل بنفسه كالمجنون والمريض الفاقد لم يكن لقيطاً بالمعنى المتقدم، ولا تجري عليه أحكامه. بل تجري عليه أحكام المجنون الذي ليس له ولي خاص. وقد تقدم التعرض لذلك في ذيل مبحث أولياء العقد من كتاب البيع. نعم يجب حفظه مع خوف التلف عليه واحترام دمه، نظير ما تقدم في اللقيط.
الفصل الثاني
في الضالة
وهي الحيوان المملوك للغير الضائع منه. أما غير المملوك كحيوانات البر الوحشية فهو ليس ضالة، بل هو من المباحات الاصلية التي يملكها من سبق إليه. ولو احتمل سبق ملك مسلم أو ذمي عليه وضياعه منه حكم بعدمه، فيجوز تملكه ولا يجري عليه حكم الضالة. نعم إذا علم بسبق مسلم أو ذمي عليه جرى عليه حكم الضالة.
(مسألة ١٢): يجوز أخذ الضالة من غير أرض الاسلام أو الذمة - وهي الارض التي يغلب عليها المسلمون أو الذميون - من دون حاجة للتعريف، ولا فرق بين العمران وغيره، ولا بين أقسام الحيوان. إلا أن يكون في أخذها مخالفة لقوانين تلك البلاد أو أعرافها بالوجه الذي يكون الخروج عليه موجباً للضرر على المسلمين أو تشويهاً لصورة الاسلام فيحرم حينئذٍ. هذا إذا لم تكن هناك أمارة على ملكية المسلم له، وإلا جرى عليه حكم ما يوجد في أرض الاسلام الذي هو موضوع الكلام الاتي.
(مسألة ١٣): من وجد حيواناً في غير العمران - كالصحاري والجبال ونحوها من المواضع الخالية من السكان - فإن لم يكن الحيوان معرضاً للتلف حرم أخذه، وذلك إنما يكون بأمرين..
الأول: أن يكون في كلأ وماء، أو يكون بحيث يمكنه الوصول إليهما لكونه صحيحاً وقريباً منهما أو بعيداً عنهما مع طاقته على الصبر عنهما مدة طويلة كالبعير، بخلاف ما لو كان مريضاً أو مجهوداً لا يستطيع السعي إليهم، أو كان صحيحاً
مع بعدهما عنه من دون أن يطيق الصبر عنهما مدة طويلة، كالحمار والبقرة.
الثاني: أن لا يتعرض للسباع ونحوها مما يفتك به، إما لعدم كون الارض مسبعة، أو لامتناعه عن السباع لقوته أو سرعة عدوه، كالبعير والفرس والثور والجاموس، بخلاف ما لو كانت الارض مسبعة ولم يكن ممتنعاً عن السباع بالذات - كالشاة - أو لصغر أو مرض أو جهد.
وإن كان الحيوان معرضاً للتلف لاحد الاُمور المتقدمة حل أخذه والاستيلاء عليه. نعم هو مكروه. إلا أن يعلم بتلفه على تقدير عدم أخذه، فلا كراهة حينئذٍ، بل قد يرجح أخذه. كما أنه تشكل الكراهة لو اطمأن الواجد له بتمكنه من إيصاله لصاحبه، بل قد يحسن أخذه حينئذٍ بقصد ذلك.
(مسألة ١٤): إذا أخذ الواجد الحيوان في الصورة الاُولى - من الصورتين المذكورتين في المسألة السابقة والتي تقدم حرمة الاخذ فيها - كان ضامناً له، ووجب عليه الانفاق عليه حفظاً له، من دون أن يرجع بنفقته على المالك لو وجده، كما لا يجوز له - مع عدم وجدان المالك - استيفاء النفقة من الحيوان نفسه - بتملكه لحصة منه أو من ثمنه - ولا من نمائه - كلبنه وصوفه وفرخه - ولا من منفعته كالركوب عليه وتحميله، بل يكون ضامناً للنماء والمنفعة أيضاً لو استوفاه، ويحرم عليه التصرف في النماء واستيفاء المنفعة مجان، بل يجب عليه حفظ النماء، أو بيعه بإذن الحاكم الشرعي وحفظ ثمنه للمالك، كما لا يجوز له استيفاء المنفعة بالضمان أو إيجار العين إلا بمراجعة الحاكم الشرعي، كما هو الحال في كل مغصوب لا يعرف صاحبه.
(مسألة ١٥): إذا أخذ الحيوان في الصورة الاُولى المذكورة وجب عليه الفحص عن مالكه وبذل الجهد في العثور عليه لتسليمه له هو ونماؤه واُجرة منفعته لو كانت، فإن يئس منه وجب عليه التصدق به عنه، كما هو الحال في كل
مال مجهول المالك. نعم الأحوط وجوباً هنا مراجعة الحاكم الشرعي في ذلك بعد أن كان متعدياً في أخذه والاستيلاء عليه.
(مسألة ١٦): إذا أخذ الواجد الحيوان في الصورة الثانية - من الصورتين المذكورتين في المسألة (١٣) والتي تقدم جواز الاخذ فيها - عرّفه حيث وجده، كما لو كان هناك أعراب قاطنين أو رحّل أو قرى قريبة، فإن عرفه صاحبه رده عليه، وإن لم يعرفه أخذه وأجرى عليه حكم ملكه ثم هو ضامن له لو وجد صاحبه، فيرده عليه أو يرد ثمنه.
(مسألة ١٧): إذا ترك الانسان حيواناً له في الطريق لجماحه أو لعجزه عن نفقته أو لأنه قد مرض أو كلّ وجهد، فإن تركه في موضع يقدر الحيوان على التعيش فيه، لأنه ذو ماء وكلأ وأمن، حرم على من يجده أخذه، بل يتركه في مكانه بانتظار رجوع صاحبه إليه، وإن أخذه ضمنه، نظير ما سبق في المسألة(١٤). إلا أن تقوم القرينة على أنه قد أعرض عنه غير ناو الرجوع إليه، كما قد يحصل في الطرق البعيدة التي يصعب الرجوع فيه، حيث قد يعلم بعدم نية المالك الرجوع حينئذٍ من أجل حيوان واحد. وإن تركه في موضع لا يقدر الحيوان على التعيش فيه - كالأرض المسبعة أو الخالية عن الماء والكلأ - جاز لواجده أخذه، ولا سبيل لصاحبه عليه بعد ذلك. إلا أن يعلم بأن المالك قد تركه ناوياً الرجوع إليه سريعاً قبل تعرضه للتلف. وكذا يجوز الأخذ إذا أعرض أهل الحيوان عنه في المدن ونحوه، لعجزهم عن نفقته أو لمرضه أو لغير ذلك.
(مسألة ١٨): إذا وجد الحيوان في العمران - وهو المكان العامر بالناس - فإن احتمل عدم ضياعه من صاحبه، وأنه قد تعود الخروج عنه لالتقاط العلف أو نحوه ثم الرجوع إليه، حرم أخذه، فإن أخذه ضمنه وجرى عليه ما تقدم في المسألتين (١٤)و(١٥). وإن علم بضياعه من صاحبه جاز أخذه وكان لقطة،
فيجري عليه حكمها الاتي في الفصل الثالث، ومنه التعريف به سنة.
(مسألة ١٩): لا فرق في الاحكام المتقدمة بين كون آخذ الحيوان كبيراً وصغيراً وعاقلاً ومجنون، إلا أن الولي في الصغير والمجنون هو يقوم مقامهما في التعريف ويتصدق أو يتملك عنهم.
(مسألة ٢٠): إذا استغنى الحيوان الملتقط في مدة التعريف عن النفقة، بمثل التقمم في المزابل أو دفع فضلات الدار له، أو كان هناك متبرع بها فذاك، وإلا أنفق عليه من نمائه أو مقابل منفعته إن كان له نماء أو منفعة مراعياً في ذلك القيمة، فإن زاد من النماء أو قيمة المنفعة المستوفاة شيء بقي للمالك تبعاً للحيوان الملتقط. وإن لم يكن للحيوان نماء ولا منفعة أو لم يكفيها لما يحتاج إليه من النفقة كان له الانفاق عليه بنية الرجوع على المالك، فإن لم يجده استوفاه من الحيوان نفسه إذا انتهت مدة التعريف.
(مسألة ٢١): إذا رأى الملتقط صلاح المالك في بيع الحيوان قبل التعريف لدفع النفقة عنه باعه وقام ثمنه مقامه في التعريف وغيره، وذلك إذا لم يكن هناك غرض عقلائي معتد به في الحيوان بشخصه، بل كان مطلوباً لماليته، لكن يلزم استئذان الحاكم الشرعي في البيع مع تيسر الوصول إليه، ومع تعذره فالأحوط وجوباً الاستعانة بمؤمن عدل ذي خبرة بذلك وإشراكه معه في الرأي.
(مسألة ٢٢): يستثنى مما تقدم في المسائل السابقة الشاة، فإن من وجدها في العمران كفاه أن يعرفها ثلاثة أيام، فإن وجد صاحبها وإلا باعها وتصدق بثمنه، فإن جاء صاحبها ولم يرض بالصدقة ضمن له الثمن. وله أن ينتظر بها أكثر من ذلك. لكن تكون نفقتها عليه، لا على المالك.
(مسألة ٢٣): إذا دخل الحيوان دار الإنسان أو نحوها من الأماكن المحجوبة لم يصدق بذلك أنه أخذه له ولا يكون في ضمانه، وله إخراجه منه، بل
يجب عليه ذلك إن احتمل عدم ضياعه من صاحبه. وإن علم ضياعه منه جاز له أخذه وجرى عليه ما تقدم في المسألة (١٨).
(مسألة ٢٤): إذا ملك الطائر جناحيه وخرج عن حوزة مالكه حل لكل أحد أخذه، فإن عرف صاحبه رده عليه، وكذا إذا جاء من يطلبه مدعياً ملكيته إذا كان ثقة غير متهم. ومع عدم الامرين يجوز لآخذه تملكه ولا حاجة للتعريف به، من دون فرق في ذلك بين كون الآخذ كبيراً وصغير، بل حتى المجنون إذا تأتى منه قصد التملك.
الفصل الثالث
في اللقطة
وهي المال المنقول الضائع غير الحيوان. ومحل الكلام منه ما يوجد في أرض الاسلام أو الذمة أو كان هناك أمارة على ملك المسلم أو الذمي له. أما ما عدا ذلك فيجري فيه ما تقدم في أول الكلام في الضالة.
(مسألة ٢٥): يجوز أخذ اللقطة لمن وجدها على كراهة، خصوصاً في لقطة حرم مكة المعظمة، وخصوصاً لمن لم يحرز من نفسه القيام بالتعريف الواجب فيه، كما هو الحال في أكثر الناس لصعوبة التعريف كما يظهر مما يأتي، بل قد يحرم عقلاً بلحاظ ذلك.
(مسألة ٢٦): إذا كان المال غير منقول كالعقار والاشجار لا يكون لقطة مع الجهل بمالكه وأخذ غيره له بل يجري عليه حكم مجهول المالك الآتي في ختام هذا الفصل.
(مسألة ٢٧): إذا كانت اللقطة دون الدرهم جاز تملكها بدون تعريف.
نعم الأحوط وجوباً السؤال ممن له خصوصية تقتضي احتمال كونها له مع معرفته، كالواقف بجنبه، ومن سبق له الحضور في موضعه، وأهل الدار لو وجدت على باب دارهم أو قريباً منه، ونحو ذلك.
(مسألة ٢٨): إذا أخذ اللقطة التي هي دون الدرهم وتملكها ثم وجد صاحبها وجب ردها إليه مع بقاء عينها مهما طال الزمان، ولا يجب دفع بدلها مع تلفه. أما مع انتقالها عن ملك الواجد وبقاء عينها وإمكان الوصول إليها فالأحوط وجوباً التصالح بين مالكها الاول والواجد ومن انتقلت إليه.
(مسألة ٢٩): الدرهم عبارة عن ثلاثة غرامات فضة إلا ربع عشر الغرام تقريب.
(مسألة ٣٠): المدار في تحديد القيمة على مكان الالتقاط وزمانه، فإذا كانت اللقطة دون الدرهم في مكان الالتقاط حين الالتقاط لم يجب التعريف بها حتى لو زادت قيمتها بعد ذلك أو في مكان آخر، والعكس بالعكس.
(مسألة ٣١): إذا بلغت اللقطة الدرهم فما زاد وجب على واجدها التعريف بها سنة، ثم هو مخير بين إبقائها عنده بانتظار صاحبه، وتملكها والصدقة به. إلا في لقطة حرم مكة المعظمة، فإن الأحوط وجوباً عدم تملكه، والاقتصار على إبقائها عنده لمالكها أو الصدقة به.
(مسألة ٣٢): لابد في المتصدق عليه في المقام من أن يكون فقير، كما هو الحال في سائر موارد الصدقة.
(مسألة ٣٣): لو عثر الملتقط على المالك بعد السنة فإن كانت اللقطة موجودة عنده ردها عليه، وإن كانت تالفة بتفريط منه ضمنها له، وإن لم يكن تلفها بتفريط منه ففي الضمان إشكال، والأحوط وجوباً الصلح بينهم. وإن كان قد تصدق بها تخير المالك بين الرضا بالصدقة ويكون أجرها له، والرجوع ببدله
على الملتقط ويكون أجر الصدقة للملتقط.
(مسألة ٣٤): يكفي التعريف سنة حتى لو احتمل العثور على المالك بالاستمرار بالتعريف. نعم لو علم بالعثور على المالك مع الاستمرار في التعريف فالظاهر وجوبه، ولو قصّر حينئذٍ وجب التعريف حتى ييأس من العثور على المالك، ولم يجز له التملك، بل يتعين عليه إبقاء العين عنده بانتظار العثور على المالك أو التصدق به.
(مسألة ٣٥): إنما يجب التعريف مع احتمال العثور به على المالك، فإذا تعذر العثور به على المالك لم يجب، كما إذا لم تكن في اللقطة علامة يمكن بها معرفة المالك، أو علم بسفر المالك للبلاد البعيدة عن موضع اللقطة بحيث لا يصله التعريف به، أو علم بأنه ليس من شأنه الاهتمام بتحصيلها والبحث عنها ولو ليأسه من وجدانه. وحينئذٍ إن احتمل بوجه معتد به العثور على المالك صدفة وجب الانتظار باللقطة سنة وإلا جازت المبادرة لتملكها أو التصدق به.
(مسألة ٣٦): يحرم الالتقاط على الواجد إذا عرف من نفسه تعذر التعريف عليه أو خشي ذلك،كما لو كان محبوساً أو منتظراً الحبس مثلاً أو كان مضطراً للخروج من بلد اللقطة، أو خشي من التعريف الضرر أو الخطر على نفسه أو على اللقطة أو نحو ذلك، إلا أن يحرز رضا المالك بالالتقاط فيما إذا كان المال ضائعاً عليه على كل حال، أو يعلم برضا الشارع الاقدس بالاخذ حينئذٍ.
وعلى كل حال إذا التقط الواجد اللقطة مع تعذر التعريف عليه وجب عليه الانتظار بها حتى ييأس من العثور على المالك، ثم له أن يتصدق به، ولا يجوز له تملكه. وهكذا الحال لو التقطها بنية التعريف ثم طرأ ما يمنع منه أو انكشف تعذره من أول الامر بالوجه المذكور.
(مسألة ٣٧): تجب على الملتقط المبادرة للتعريف بعد الالتقاط بالوجه
المتعارف، وإن لم يبادر - عصياناً أو لعذر - لم يكتف بالسنة بل يجب عليه الفحص عن المالك بعد السنة حتى ييأس منه، ثم له أن يتصدق بالعين، ولا يجوز له تملكه. وكذا الحال إذا بادر للتعريف ثم قطعه قبل إكمال السنة مدة طويلة على خلاف المتعارف.
(مسألة ٣٨): لا تجب مباشرة الملتقط للتعريف، فيجوز له الاستنابة فيه بل يجزئ التعريف من المتبرع.
(مسألة ٣٩): إذا احتاج التعريف لبذل مال كان على الملتقط لا على المالك، وكذا إذا احتاج حفظ اللقطة - عن السرقة أو التلف أو الضرر - لبذل مال. نعم إذا كان الالتقاط بطلب من الحاكم الشرعي لمصلحة المالك بمقتضى ولايته كان له جعل النفقة على المالك.
(مسألة ٤٠): إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر وجب عليه التعريف به، فإن وجد صاحبها دفعها إليه، وإن وجد الملتقط الاول دفعها إليه وكان على الملتقط الاول إكمال التعريف حتى تتم السنة ولو بضميمة تعريف الملتقط الثاني.
هذا إذا لم يظهر من الملتقط الاول البناء على الخيانة والتقصير في أمره، وإلا حرم على الملتقط الثاني دفعها إليه لو وجده، بل يجب عليه إكمال التعريف بنفسه حتى يجد المالك. والأحوط وجوباً حينئذٍ أن لا يجتزئ بتعريف الاول، بل يعرفها سنة من حين وجدانه له، كما هو المتعين لو لم يعلم بأنها لقطة قد ضاعت من الملتقط. فإذا تمت السنة كان مخيراً بين الاُمور الثلاثة كالملتقط الاول.
(مسألة ٤١): لابد في التعريف باللقطة من تجنب ما يوجب إيهام المالك وانصراف ذهنه عنه، فإذا كانت نسيجاً مخيطاً لم يكف أن يقول: من ضاع له نسيج، إذا كان النسيج ينصرف لغير المخيط، وإذا مرت على اللقطة مدة
طويلة لم يكف التعريف بما يوهم قرب ضياعه. بل إذا كان في اللقطة بعض الخصوصيات التي يكون ذكرها منبهاً للمالك عليها ومثيراً لاحتماله إرادتها من التعريف ومحفزاً على طلبها وجب ذكره، ككونها ذهباً أو فضة أو مصوغاً أو مخيطاً أو غير ذلك. نعم لابد من الابهام من بعض الجهات بالنحو الذي يحتاج معه إلى ذكر العلامة التي يختص بمعرفتها المالك.
(مسألة ٤٢): يجب في التعريف تحري المواضع التي يتوقع من التعريف فيها اطلاع المالك عليه إما لبحثه عن اللقطة فيها أو لحضوره فيها أو لوصول نبأ التعريف منها إليه، وهو يختلف باختلاف الامكنة والاحوال والازمنة، ففي اللقطة في المدينة يكون التعريف في المواضع القريبة من مكان اللقطة التي يتعارف فحص المالك عن اللقطة فيها وفي الاماكن والمجامع العامة التي يتوقع حضور المالك فيها أو شيوع التعريف فيها بين أهل المدينة حتى يطلع المالك عليه. وفي لقطة الصحراء يكون التعريف للنازلين في موضع اللقطة وفي الاماكن القريبة منه. وفي اللقطة في منازل المسافرين يكون التعريف في موضع الالتقاط وفي المنازل المتأخرة عنه حتى ينتهي إلى بلد المسافرين. وفي اللقطة في أيام المواسم التي يجتمع فيها الناس من مختلف البلدان - كالحج والزيارات - يكون التعريف في المشاهد وفي البلدان التي يجتمع فيها الناس ويرجعون إليها بعد انقضاء الموسم لو تيسر الوصول إليه... إلى غير ذلك.
(مسألة ٤٣): يجب تتابع التعريف في ضمن السنة بحيث يصدق عرفاً استمرار التعريف فيها وعدم انقطاعه وذلك يختلف باختلاف كيفية التعريف وباختلاف الاعراف والعادات التي تجري عليها الناس في ذلك.
(مسألة ٤٤): إذا ادعى اللقطة مدع وعلم صدقه - إما لوثاقته في نفسه أو لذكره علامات لا يطلع عليها غير المالك عادة، أو لغير ذلك - فلا إشكال،
وكذا إن قامت البينة على ملكيته له. وبدونهما لابد من الاطمئنان بصدقه بذكره علامات للقطة يبعد اطلاع غير المالك عليه. ولا يكفي مجرد ذكره للعلامات إذا احتمل بوجه معتد به اطلاعه عليهامن المالك أو نحوه، بل لا يكفي ذلك وإن أوجب الظن إذا لم يوجب الاطمئنان.
(مسألة ٤٥): لا يشترط العلم أو البينة أو الاطمئنان بكون الشخص هو المالك الواقعي في جواز دفع اللقطة إليه، بل يكفي العلم أو البينة أو الاطمئنان بكونه صاحب اليد عليها قبل الضياع وإن احتمل عدم ملكيته لها واقع، بل وإن علم ذلك إذا ادعى كونه وكيلاً من قبل المالك أو ولياً عليه أو نحو ذلك ممن يحق له الاستيلاء على العين والمطالبة به. نعم مع العلم بأن يده عادية - كالسارق لها والذي يأخذها بعقد فاسد ونحوهما - لا يجوز دفعها إليه، بل لابد من الفحص عن المالك - الواقعي أو الظاهري - أو من يقوم مقامه، ومع عدم العثور عليه يجري ما سبق. وكذا إذا ادعى الوكالة أو الولاية أو نحوهما ولم يثبت سبق يده على اللقطة، فإنه لا يجوز دفعها إليه ما لم تثبت دعواه بوجه شرعي.
(مسألة ٤٦): إذا عرف المالك وتعذر إيصال اللقطة إليه أو إلى وكيله أو وليّه، فإن كانت مما يصرف بعينه كالطعام واللباس وعلم رضا المالك بصرفها بعينها في بعض الوجوه - كبذلها للفقراء ليأكلوها أو يلبسوها - حلَّ ذلك. ولا يكفي ذلك في جواز بيعها وإنفاق ثمنه. وفي غير ذلك إن أمكن الرجوع له في كيفية التصرف فيها وجب، وإن تعذر وجب حفظها للمالك مهما طال الزمان. نعم مع اليأس من الوصول له أو لوارثه لابد من الرجوع للحاكم الشرعي في كيفية التصرف فيها بدلاً عن المالك.
(مسألة ٤٧): لا يجوز دفع اللقطة للحاكم الشرعي ليستقل بإجراء حكمها ولا تبرأ الذمة بذلك. إلا أن يكون الدفع إليه راجعاً إلى توكيل الملتقط
له في التعريف بها وإجراء أحكامه، فلا تبرأ الذمة إلا بقيامه بذلك، كما هو الحال في سائر الوكلاء.
(مسألة ٤٨): إذا حصل للقطة نماء في مدة التعريف كان للمالك تبعاً للعين فيأخذه معها إذا عثر عليه بالتعريف، وكذا إذا لم يعثر عليه وبقيت العين والنماء عند الملتقط بانتظار العثور على المالك. أما إذا أراد الملتقط تملكها فله تملك النماء معها إذا كان متصلاً به، كالسمن والصوف قبل جزه. أما إذا كان منفصلاً ففي جواز تملكه معها إشكال، والأحوط وجوباً إجراء حكم مجهول المالك عليه، فيقتصر على الصدقة.
(مسألة ٤٩): إذا مات الملتقط بعد تملك اللقطة انتقلت لوارثه مع بقاء عينه، فإن جاء المالك لزم الوارث إرجاعها له مع وجوده، وضمانها من أصل التركة إذا كانت قد تلفت في حياة الملتقط، وكذا إذا كانت قد تلفت بعد وفاته بغير تفريط من الوارث. أما إذا تلفت بتفريط منه فإنه يضمنها من ماله لا من التركة.
هذ، وأما إذا مات الملتقط قبل تملكه للقطة فالأحوط وجوباً أن لا يتملكها الوارث، بل يتم تعريفها إن كان لم يتم، ثم يحفظها للمالك أو يتصدق به، فإن جاء المالك ولم يرض بالصدقة ضمنه.
(مسألة ٥٠): يجري على التقاط الصبي والمجنون ما تقدم في الضالة.
(مسألة ٥١): إذا كانت اللقطة مما يفسد بالبقاء - كالخضر والفواكه والطعام المطبوخ - وجب على الملتقط تقويمها بالثمن على نفسه، ثم يتصرف فيها ثم يعرفها ويقوم الثمن مقامها في الاحكام المتقدمة بعد التعريف.
وأما بيعها على غيره فهو إنما يجوز بثمن المثل فما زاد، وإذا لم يجد من يشتريها بثمن المثل كان النقص عليه. نعم إذا كان الالتقاط بطلب من الحاكم الشرعي لمصلحة المالك بمقتضى ولايته كان له الاتفاق معه على مقدار الثمن
الذي يقومها به على نفسه أو يبيعها به على غيره.
ويجري ذلك فيما إذا طرأ عليها ما يمنع من البقاء بعد الالتقاط قبل إكمال التعريف أو بعده.
(مسألة ٥٢): نظير فساد اللقطة بالبقاء العملة إذا تعرضت للسقوط المالية بسبب إلغاء الدولة له. والاعيان التي يتوقع عليها السرقة في ظروف طارئة ونحو ذلك.
(مسألة ٥٣): المال الموجود في الدار العامرة يراجع فيه أهله، فإن أدعو ملكيتهم له أو ملكية غيرهم أو نفوه عنهم أو عن غيرهم صدّقو. وإن جهلوا الامر فإن كانت الدار لايدخلها غيرهم حكم بأنه لهم، وكذا إذا وجد في مكان منها يختص بهم، ولا يدخله غيرهم. وإن كانت الدار يدخلها غيرهم ووجد في مكان منها لايختص بهم، فإن كان الذي يدخلها محصوراً في أشخاص معينين لزم مراجعتهم في المال فإن علم أنه لاحدهم فذاك، وإن تردد بين أكثر من واحد فالأحوط وجوباً التصالح بينهم، وإن كان الذي يدخلها كثير غير محصورين جرى عليه حكم اللقطة في التعريف وغيره.
(مسألة ٥٤): المال الموجود في الدار الخربة التي هجرها أهلها وتركوها إن احتمل العثور على صاحبه بالتعريف عرف به، فإن لم يوجد له صاحب فهو لواجده، ولا ينتظر به سنة. وكذا إذا كان ميؤوساً من العثور على صاحبه بالتعريف. نعم لو هجر الخربة أهلها ولم يتركوها بل بقيت محجوبة لهم يتعاهدونها فهي بحكم الدار العامرة. هذا كله إذا لم يكن مدفون، أما المدفون فقد تقدم حكمه في مسائل الكنز من كتاب الخمس.
(مسألة ٥٥): إذا كان للانسان صندوق أو نحوه محجوب معد لحرز المال وحفظه فوجد فيه مالاً وشك في أنه له أو ل. فإن كان الصندوق مختص
به لا يودع فيه غيره إلا وكالة عنه حكم بأن المال له، ولا يعتني باحتمال كونه لغيره أمانة عنده أو أنه قد سقط من وكيله بلا قصد أو نحو ذلك. وإن كان مشتركاً بينه وبين غيره عرفه ذلك الغير، فإن عرفه فذاك، وإن نفاه عنه وكان الامر منحصراً بينهما صار لصاحب الصندوق، وإن شك ذلك الغير بحيث تردد الامر بينهم، فالأحوط وجوباً التصالح بينهم. أما لو لم يكن الصندوق محجوباً ولم يعد لحرز المال - بل يوضع فيه المال كما يوضع في سائر الامكنة - فإن اختص بأهل الدار فالمال مردد بينهم وإن كان عاماً جرى عليه حكم ما يوجد في الدار التي يدخلها كل أحد. لكنه فرض لا يوجد غالب.
(مسألة ٥٦): إذا غرقت السفينة فما طاف على الماء أو قذف به الماء على الساحل فهو لاهله، فإن عرفوا دفع لهم، ومع الجهل بهم لو أخذه غيرهم جرى عليهم حكم اللقطة، وأما ما بقي في أعماق الماء فإن صار أهله في مقام استخراجه لم يحل لأحد سبقهم إليه، وما تركوه - ولو لعجزهم عن استخراجه - فهو لمن استخرجه بالغوص أو نحوه.
(مسألة ٥٧): إذا تبدل متاع الانسان بمتاع غيره من حذاء أو لباس أو غيرهم، كما يتعارف كثيراً في المواضع العامة. فإن علم أن الذي بدَّله قد تعمَّد ذلك واعتدى عليه جاز للآخر أخذ البدل من باب المقاصة، التي تقدم الكلام فيها في آخر كتاب الدين. فإن كان البدل الباقي أكثر قيمة من متاعه الذي أخذه المتعدي بقي الزائد ملكاً له، فإن عرفه أوصله له، وإن جهله جرى على الزائد حكم مجهول المالك. إلا أن يعلم أن المتعدي تركه ليؤخذ بدلاً عما أخذه فيجوز أخذه بتمامه وإن كان أكثر قيمة.
وإن احتمل غفلته عن ذلك وعدم تعمده جرى على البدل حكم مجهول المالك، فلا يجوز التصرف فيه إلا أن يحرز رضا صاحبه لو علم بالحال. كما يجب الفحص عن المالك، ومع اليأس عن معرفته أو عن الوصول إليه - بعد
الفحص أو بدونه - يستأذن الحاكم الشرعي في أن يستوفي منه قيمة ما أخذه، ويتصدق بالزائد.
تتميم: وفيه أمران..
الأول: لابد في كون الشيء لقطة من أخذ الشخص له حال ضياعه من صاحبه. ولا تصدق في غير ذلك من موارد الجهل بالمالك، كالامانة والمقبوض بالعقد الفاسد والمغصوب والمأخوذ خطأ إذا ضاع أصحابها ولم يعرفو، وكما إذا نسي الشخص متاعه في مكان لغيره أو إذا دفع المشتري للبائع أكثر من مقدار الثمن أو دفع البائع للمشتري أكثر من المقدار الذي اشتراه إلى غير ذلك من موارد وقوع المال بيد غير مالكه. وفي جميع ذلك يجب الفحص عن المالك مع احتمال العثور بالفحص عليه احتمالاً معتداً به، ولا يكتفى بالسنة حتى في المأخوذ من السارق على الأحوط وجوب، ومع تعذر الفحص أو اليأس من العثور على المالك بسببه إن احتمل بوجه معتد به العثور على المالك من دون فحص أو مجيئه بنفسه لطلب ماله وجب انتظاره، ومع اليأس عن معرفة المالك لا يجوز لمن عنده المال تملكه، بل له أن يتصدق به عن المالك لا غير. فإن عثر على المالك بعد التصدق بالمال فالأحوط وجوباً مراجعته فإن رضي بالتصدق كان له أجره، وإن لم يرض ضمن له المتصدق المال وكان أجر الصدقة للمتصدق.
(مسألة ٥٨): يجوز مباشرة من عنده المال للتصدق بنفسه، كما يجوز له التوكيل فيه.
(مسألة ٥٩): لا يجب استئذان الحاكم الشرعي في التصدق بمجهول المالك، كما لا يجزئ الدفع إليه. نعم لو دفع المال إليه - على أنه وكيل عنه في التصدق أو لانه الاعرف بمواقع الصدقة أو لغير ذلك - فتصدق به أجز.
(مسألة ٦٠): يجوز الصدقة بعين المال، كما يجوز الصدقة بثمنه بعد تقويمه على نفسه أو بيعه من غيره. لكن لابد في الابدال بالثمن من وجود مرجح لذلك، كعدم انتفاع الفقير بالعين أو نحو ذلك. كما أن الأحوط وجوباً حينئذٍ استئذان الحاكم الشرعي. وإذا تيسر التصدق بعين المال على الفقير ثم شراؤه منه بما يتفقان عليه كان أولى.
(مسألة ٦١): إذا خشي من بيده المال عليه التلف أو النقص أو نحوهما قبل اليأس من المالك وكانت المصلحة في إبداله بالمثل أو القيمة جاز له ذلك. والأحوط وجوباً حينئذٍ مراجعة الحاكم الشرعي واستئذانه في ذلك مع الامكان.
(مسألة ٦٢): إذا تصرف من بيده المال في المسألتين السابقتين من دون إذن الحاكم الشرعي ثم راجعه فأمضى التصرف نفذ وهكذا الحال في جميع موارد مراجعة الحاكم الشرعي.
(مسألة ٦٣): إذا تعددت الايدي على مجهول المالك كان الكل مسؤولاً به، فإن تصدق به أحدهم أجزأ عن الباقين، وكان للمالك الرجوع على أي منهم شاء، بناء على الاحتياط السابق من الضمان له لو لم يرض بالصدقة. نعم إذا تولى أحدهم التصدق وكالة عمن سبقه فلا ضمان عليه، بل الضمان على الموكل الذي كان المال عنده قبله.
(مسألة ٦٤): إذا أراد من عنده المال المجهول المالك الصدقة به فلا بد من أن يتصدق به على فقير غيره، ولا يجزئ أخذه له على أنه صدقة على نفسه حتى لو كان هو فقيراً ومصرفاً للصدقة. نعم لا بأس بأن يدفعه إلى غيره من أجل أن يتصدق به عليه، لما سبق من أن التصدق وظيفة كل من يكون المال تحت يده. لكن لابد من وقوع التصدق منه استقلال، لا وكالة عمن كان عنده.
(مسألة ٦٥): لا يجري حكم مجهول المالك على الدين المجهول المالك،
كما تقدم في فروع المال المختلط بالحرام من كتاب الخمس، وفي المسألة الثانية والخمسين من كتاب الدين.
الثاني: إذا أعرض المالك عن ملكه جاز لغيره أخذه وتملكه. لكن الاعراض على نحوين..
أحدهما: راجع إلى الاذن في تملك المال الذي يعرض عنه، مثل ما يلقيه أهل الدار في المزابل، وما يلقيه أهل العمل من الالات المستهلكة (السكراب) وما يتركه صاحب القماش عند الخياط من قطع القماش الصغيرة التي لا ينتفع هو بها ونحو ذلك. وحينئذٍ يترتب على ذلك حكم الهبة فيجوز الرجوع فيه ما لم يتصرف الاخذ في العين تصرفاً مغيراً له.
ثانيهما: راجع إلى الاعراض عن المال تخلصاً من كلفته، كترك الحيوان للتخلص من الانفاق عليه وترك المال الذي يغرق بعدم تيسر الغوص له وإخراجه كما تقدم التعرض له آنف، وترك الحيوان في الطريق إذا جهد وأعيى عن السير الذي تقدم التعرض له في الفصل الثاني، وترك الحيوان الوحشي إذا أفلت وفرّ في البيداء ونحو ذلك. والظاهر جواز تملك المال حينئذٍ لمن تكلف تحصيله وأخذه، ولا يحق لصاحبه الاول المطالبة حتى مع بقاء المال على حاله. نعم لابد من إحراز إعراض المالك عنه وعدم سعيه لتحصيله، ولو من ظاهر الحال. أما لو اهتم بتحصيله والبحث عنه فيجب على غيره أن يدفعه له لو تكلف تحصيله، وليس له الامتناع من ذلك ولا المطالبة بما أنفقه في سبيل تحصيله حينئذٍ.
والحمد لله رب العالمين
كتاب الصيد والذباحة
يحرم أكل الميتة كما يأتي، وهي أيضاً نجسة إذا كانت لحيوان ذي نفس سائلة، كما تقدم في محله. والمراد بالميتة في محل الكلام كل حيوان مات من دون تذكية. والكلام هنا فيما تتحقق به التذكية، وهو الصيد والذباحة، فيقع الكلام في بابين..
الباب الاول
في الصيد
وفيه فصلان..
الفصل الاول
في صيد ما له نفس سائلة
ويختص بالحيوان الوحشي الممتنع كأكثر الطيور والبقر والحمار الوحشيين والظبي والأيل ونحوه. دون الحيوانات الاهلية كالابل والبقر والغنم والدجاج ونحوه. وإذا توحش الحيوان الاهلي وامتنع حل بالصيد كالوحشي، وإذا تأهل الوحشي لم يحل بالصيد كالاهلي وكذا إذا لم يمتنع لكونه في قبضة الانسان، كالغزال يصاد ويربط أو يحبس في الحظيرة. وفرخ الحيوان
الوحشي قبل أن يمتنع ويقوى على الفرار فإنه لا يحل بالصيد كالاهلي، وكذا فرخ الطير قبل أن يملك جناحيه ويمتنع بالطيران.
إذا عرفت هذ، فآلة الصيد أمران..
الأول: الحيوان. ويختص بالكلب ولا يحل صيد غيره من سباع الطير والبر، كالصقر والبازي والعقاب والفهد والنمر والذئب والاسد وغيره، إلا إذا اُدركت ذكاته.
(مسألة ١): لا فرق في الكلب بين السلوقي وغيره. نعم الأحوط وجوباً عدم التذكية بالكلب الاسود البهيم، وهو الشديد السواد الذي لا يخالط سواده لون آخر.
(مسألة ٢): يشترط في الكلب الذي يصطاد أن يكون معلم، بأن يتدرب على الصيد لصاحبه ويتعلمه بالتعليم. وهو أمر عرفي يدركه أهله. قيل: وذلك بأن يسترسل إذا اُرسل وينزجر إذا زجر. والظاهر أن ذلك من لوازم التعليم في الجملة. وليس هو تمام معناه.
(مسألة ٣): لابد في حل الصيد بالكلب من أن يسترسل الكلب بإرسال الصائد وتهييجه، بحيث ينسب الصيد للمرسل، ويكون الكلب كالالة له، فلو هاج الكلب بنفسه أو أفلت من صاحبه مع زجره له لم يحل صيده.
(مسألة ٤): لو هاج الكلب بنفسه نحو الصيد فأغراه صاحبه به فأسرع بسبب ذلك إليه فصاده ففي حل الصيد بذلك إشكال. نعم لو كان هياجه بانتظار أمر صاحبه، بحيث لو زجره فانزجر فأغراه صاحبه فاسترسل وصاد حل صيده. وأظهر منه ما إذا زجره فوقف، ثم أرسله فاسترسل وصاد.
(مسألة ٥): إذا أرسله لغرض غير الصيد - كتعليمه على الصيد أو طرد عدو أو مهاجمة سبع - فاصطاد حيواناً لم يحل ما صاده. بل لو أرسله لصيد
حيوان خاص فصاد غيره ففي حل ما صاده إشكال والأحوط وجوباً العدم.
(مسألة ٦): إذا أرسله للصيد من دون أن يرى المرسل صيد، بل برجاء أن يرى الكلب صيد، فصادف أن رآه فصاده حل. وكذا إذا أرسله على شبح برجاء أن يكون حيواناً يصاد، فصادف ذلك وصاده.
(مسألة ٧): لا فرق في المرسل بين أن يكون واحداً ومتعدد، وكذا الحال في الكلب وفي الصيد، فإذا أرسل شخص واحد أو أكثر كلباً معلماً واحداً أو أكثر على حيوان واحد أو أكثر حل الصيد في الجميع. نعم لابد من تمامية الشروط فيها جميع، ولا يحل مع عدم تماميتها في بعضه، كما لو كان غير معلم أو قد هاج بنفسه أو قد أرسله كافر، أو تعمد من أرسله عدم التسمية. نعم إذا علم باستناد موت الصيد لواجد الشرط دون فاقده حل الصيد.
الثاني من آلتي الصيد: السلاح، سواءً كان قاطع، كالسيف والسكين والخنجر، أم شائكاً كالرمح والسهم والحربة ونحوه.
(مسألة ٨): ما كان من السلاح من الحديد ونحوه من الفلزات الصلبة - كالصفر والذهب - أو مشتملاً على نصل من ذلك يحل الصيد به إذا قتله وإن لم يخرق اللحم. نعم الأحوط وجوباً المبادرة لآخراج الدم بالنحو المتعارف وعدم أكل الصيد إذا بقي دمه فيه. وأما ما لا يشتمل على ذلك كالخشب المحدد فلا يحل الصيد به إلا أن يخرق لحمه.
(مسألة ٩): في جواز الصيد بالالات القاطعة والشائكة مما لا يعد سلاحاً إشكال، والأحوط وجوباً العدم، وذلك كالمنجل والمنشار والمزرف والدرنفيس والمخيَط والفالة. إلا أن يتخذ سلاحاً ولو في خصوص مكان، فيحل الصيد به.
(مسألة ١٠): يحل الصيد بالطلقات النارية المتعارفة في زماننا إذا كانت محددة الطرف شائكة. وأما الكروية الشكل ففي الصيد بها إشكال والأحوط
وجوباً العدم. وأشكل منها الطلقات الحارقة إذا لم تكن محددة الطرف وتنفذ في البدن.
(مسألة ١١): لا يحلّ الصيد المقتول بالحجارة والعمود والشرك والحبالة، وكذا بالضرب معترضاً بمثل المسحاة ونحو ذلك مما يصاد به ولا يكون قاطعاً ولا شائك.
(مسألة ١٢): يشترط في حلّ الصيد بالآلة قصد الصائد الصيد به، فلو رمى لا بقصد الصيد فأصاب حيواناً فقتله لم يحل وإن سمى بعد ما رماه. نعم لو رمى وسمى من دون أن يرى صيداً بل برجاء أن يصيب صيداً فأصابه وقتله حل، نظير ما تقدم في الصيد بالكلب.
(مسألة ١٣): إذا رمى صيداً فوصلت الرمية للصيد بمعونة الريح فقتلته، بحيث لولا الريح لما وصلت إليه حل الصيد وكذا إذا اصطدمت بالارض ثم وثبت للصيد فقتلته.
(مسألة ١٤): إذا رمى صيداً فأخطأه وأصاب غيره فقتله حلّ.
(مسألة ١٥): لا فرق في الرامي بين أن يكون واحداً أو متعدداً وكذا الحال في الصيد في الآلة التي يصاد بها نظير ما تقدم في الصيد في الكلب. بل لو اشترك في الصيد الكلب والآلة حل إذا جمعا الشرائط، نظير ما تقدم أيض.
(مسألة ١٦): يشترط في حلّ الصيد إسلام الشخص الذي يتولاه، وهو المرسل للكلب والرامي بالآلة فيحل صيد المسلم مؤمناً كان أو مخالف، كبيراً أو صغيراً مميزاً يتحقق منه القصد للصيد. ولا يحل صيد الكافر، ذمياً كان أو حربي، كتابياً كان أو غيره. ويأتي في الذباحة ما ينفع في المقام.
(مسألة ١٧): يشترط في حلّ الصيد التسمية من الصائد عند إرسال الكلب أو رمي الآلة، أو بعد ذلك قبل إصابتهما للحيوان، فإن تعمد تركها حرم
الصيد حتى لو كان جاهلاً باشتراطه. نعم لو كان من شأنه الإتيان بها لكنه تركها نسياناً حل الصيد سواءً كان يرى اشتراطها أم ل، بل يأتي بها تبركاً أو لبنائه على استحبابه.
(مسألة ١٨): لابد من التسمية من نفس مرسل الصيد، ولا يكفي من غيره عند إرساله الكلب أو رميه بالآلة.
(مسألة ١٩): يكفي في التسمية ذكر الله تعالى في ضمن جملة تتضمن التعظيم، مثل: بسم الله، و: الله أكبر، و: الحمد لله. ويشكل الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجرد، أو مع وصف يتضمن التعظيم من دون أن تتم به جملة، كما لو قال: الله العظيم. وكذا الاكتفاء بالنداء بمثل: يا الله.
(مسألة ٢٠): الأحوط وجوباً الاقتصار في اسمه تعالى على لفظ الجلالة، وعدم الاجتزاء بترجمته بغير العربية من اللغات لاهل تلك اللغة.
(مسألة ٢١): يجوز صيد الأخرس وتسميته بتحريك لسانه وإشارته بتحريك إصبعه.
(مسألة ٢٢): الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية بعنوان كونها على الصيد ومن أجله ولا تجزئ التسمية حين الصيد بداع آخر.
(مسألة ٢٣): يشترط في حل الصيد استناد موت الحيوان للسبب المحلل، كجرح الكلب وعقره والاصابة بالسلاح أما إذا استند إلى سبب آخركصدمة أو تردّ من شاهق أو غرق في ماء أو غير ذلك - فلا يحل سواء استند الموت للسبب الآخر وحده أم لهما مع. ولو شك في ذلك حرم ظاهر. إلا مع عدم ظهور السبب الآخر وعدم المثير عرفاً لاحتماله، بحيث يطمأن نوعاً باستناد الموت للسبب المحلل.
(مسألة ٢٤): يحرم الصيد على المحرم ولو في غير الحرم، كما يحرم الصيد
في الحرم ولو لغير المحرم. ولا يحل الحيوان حينئذٍ حتى على المحل على ما ذكر في كتاب الحج مفصل.
(مسألة ٢٥): إنما يحل الصيد بالسبب المحلل - من جرح الكلب والاصابة بالسلاح - إذا لم يدرك الصائد ذكاته بالذبح، إما بأن يدركه ميتاً أو حياً في زمن لا يسع الذكاة، وكذا إذا اشتغل بمقدمات التذكية القريبة كسل السكين والاستقبال به فمات. أما إذا أدرك ذكاته فلم يذكه حتى مات فإنه لا يحل، حتى لو كان لعدم وجود آلة التذكية عنده. نعم إذا كان صيده بالكلب ولم يكن له ما يذكيه به كان له أن يغري الكلب به حتى يجهز عليه، ويحل بذلك حينئذٍ.
(مسألة ٢٦): لا يجب مبادرة الصائد للصيد - ليدرك ذكاته - ما دام الصيد ممتنع، فإذا حبسه الكلب أو أقعده أو أثخنه الرمي حتى وقف، فإن علم بأنه لو بادر إليه لم يدرك ذكاته لم يجب عليه المبادرة إليه ويحل بقتل الكلب له أو بنزف دمه حتى يموت، وإن احتمل أنه يدرك ذكاته لو بادر إليه فالأحوط وجوباً المبادرة إليه ليدرك ذكاته فلو لم يبادر إليه حينئذٍ لم يحل، إلا أن يعلم بعد ذلك أنه لو كان قد بادر إليه لم يدرك ذكاته.
نعم لا يضر عدم المبادرة للانشغال بغيره من الصيد فيما لو تعدد الصيد، أو للانشغال بحفظ متاعه من السرقة، أو بإمساك الحيوان الذي يركبه من الشرود ونحو ذلك. وإنما الاشكال في عدم المبادرة اعتباطاً وتسامحاً بانتظار موته بنزف دمه ونحوه.
(مسألة ٢٧): إذا فقد الصيد بعض الشروط المتقدمة فمات حرم، وإن أدرك الصائد أو غيره ذكاته فذكَّاه حلَّ، إلا الصيد في الحرم أو من الحرم فإنه لا يحل على ما يذكر في كتاب الحج.
(مسألة ٢٨): يكفي في إدراك تذكية الحيوان - في المسائل المتقدمة - أن
يدركه حيَّ. ولو شك في ذلك كفى أن يحرك عينه أو يده أو اُذنه أو ذَنَبَه.
(مسألة ٢٩): الصيد إنما يوجب حلية الحيوان من حيثية التذكية، مع حرمته من حيثية نجاسة موضع الدم وموضع عضة الكلب ونحوهم، فلا يحل إلا بعد تطهيره.
(مسألة ٣٠): إذا قطع رأس الصيد فمات حل جميعه، وإن أدركه الصائد وفيه بقية من الحياة ففي وجوب تذكيته من موضع التذكية إن لم يقطع منه إشكال، وإن كان أحوط وجوب. هذا إذا كان الصيد واجداً للشرائط، وإن كان فاقداً لها حرم حتى إذا كان فيه بقية من حياة فذكى في موضع التذكية على الأحوط وجوب.
(مسألة ٣١): إذا قطع عضواً من الصيد غير الرأس كاليد والرجل والذنب أو قطعة منه صغيرة حرم المقطوع وحده وحل ما بقي من الحيوان مع تحقق شروط الصيد أو تذكيته بعد إدراكه حي.
(مسألة ٣٢): إذا قطع الحيوان قطعتين فإن كانتا متقاربتين في المقدار حلتا جميعاً مع تمامية شروط الصيد، والأحوط وجوباً تذكية ما فيه الرأس مع إدراك ذكاته. وإن لم تتم شروط الصيد حرمتا جميعاً حتى ما فيه الرأس وإن أدركه حياً فذبحه بالوجه الشرعي على الأحوط وجوب. وإن اختلفتا قدراً بوجه ظاهر حلت الكبرى إن كانت في جانب الرأس والأحوط وجوباً تذكيتها مع إدراك ذكاته. وفي حلية ما عداها إشكال. هذا مع تمامية شروط الصيد، ومع عدم تماميتها حرم الجميع حتى الكبرى إذا كانت في جانب الرأس مع إدراكها حية وذبحها بالوجه الشرعي على الأحوط وجوب. إلا أن يصدق عليها أنها حيوان ناقص، كما لو قطعت الرجل مع بعض المؤخر فإن الباقي يحل بالتذكية.
(مسألة ٣٣): الصيد بالآلة كما يذكي ما يحل أكل لحمه يذكي ما يحرم أكل
لحمه، فينتفع بجلده. نعم لابد أن يكون الحيوان في نفسه قابلاً للتذكية، ويأتي بيان ذلك في الذباحة. أما الصيد بالكلب فهو يذكي ما يحل أكل لحمه، ولا يذكي ما يحرم أكل لحمه.
(مسألة ٣٤): يملك الانسان الحيوان المباح بالاصل بأخذه له، كما إذا قبض على يده أو رجله أو رماه بانشوطة بنحو يحبسه بذلك، وكذا إذا دخل حجرته فأغلق عليه بابه وحبسه. وكذا إذا نصب شبكة أو شركاً أو نحوهما مما يحبس الحيوان بقصد صيده وأخذه، فإنه يملكه إذا وقع فيها وانحبس. وكذا إذا أرسل عليه الكلب ليصيده به فاستولى عليه وحبسه. وأما إذا رماه فقتله أو أقعده فصيّره غير ممتنع - كما إذا كسر جناحه فمنعه من الطيران أو كسر رجله أو جرحه بنحو يمنعه من العدو - ففي تملكه بمجرد ذلك من دون أن يأخذه ويصير في حوزته إشكال، وكذا إذا عقره الكلب من دون أن يحبسه. فيلزم الاحتياط في ذلك في حق الفاعل بعدم ترتيبه أثر الملكية إلا بعد أخذه له، وفي حق غيره بعدم التصرف فيه ولا التملك إلا بإذنه.
(مسألة ٣٥): إذا توحل الحيوان في أرضه أو انحبس الطائر في بيته أو وثبت السمكة في سفينته لم يملك شيئاً من ذلك، إلا أن يصدر منه ما يحقق أخذه له ناوياً ذلك، كما إذا أغلق الباب على الحيوان أو الطائر أو ساق السفينة والسمكة فيه. أما إذا أعد شيئاً من ذلك ليأخذ به الحيوان - كما إذا أجرى الماء في أرضه فأوحلها وفتح المضيق في بيته لينحبس فيهما الحيوان والطائر، أو وضع سفينته في مكان ليثب فيها السمك - فإنه يملكه حينئذٍ بذلك.
(مسألة ٣٦): أخذ الحيوان في المسألة السابقة إنما يوجب تملك الآخذ له إذا كان بنية تملكه له، كما هو الحال في سائر المباحات الاصلية، أما إذا لم يكن بنية التملك فهو لا يوجب الملك، كما إذا أخذه ليعرف مدى قوته، نظير ما إذا أخذ
حجراً ليرمي به ويعرف مدى رميته.
(مسألة ٣٧): إذا أخذ الحيوان في المسألة السابقة بأحد الوجوه المتقدمة ثم أفلت منه، فإن كان ذلك قبل استحكام الحبس، بحيث لا يصدق معه الاخذ للحيوان وحيازته فالحيوان باق على إباحته الاصلية ولم يملكه الاخذ، بخلاف ما إذا كان بعد استحكام الحبس وصدق الاخذ، كما إذا قبض عليه حتى تعب فضعف عن إمساكه وأفلت، وكما إذا أغلق عليه الباب ثم فتحها شخص ففر الحيوان، أو توحل حتى إذا جف الوحل قوي الحيوان على التخلص منه ونحو ذلك. وحينئذٍ يبقى الحيوان في ملك الاخذ، ولا يجوز لغيره صيده أو قتله إلا أن يأذن في ذلك، أو يتحقق منه الاعراض عن الحيوان - ولو بسبب الافلات - الذي تقدم الكلام فيه في آخر كتاب اللقطة.
(مسألة ٣٨): إذا شك في سبق وضع اليد على الحيوان بني على عدمه، أما إذا علم بذلك فإن عرف صاحب اليد عليه وجب تسليمه له، وإن جهل جرى على الحيوان حكم اللقطة المتقدم. نعم إذا ملك الطائر جناحيه فأخذه شخص ولم يعرف صاحبه جاز له تملكه، كما تقدم في آخر الفصل الثاني من كتاب اللقطة.
(مسألة ٣٩): إذا تبع حيواناً فركض الحيوان حتى أعيى ووقف لم يملكه الذي تبعه حتى يأخذه، فإن سبقه غيره وأخذه ملكه الاخذ، دون الذي تبعه.
(مسألة ٤٠): الصيد بالكلب والالة المغصوبين يحرم من حيثية التصرف بالمغصوب، ويترتب عليه التذكية، كالصيد بالمملوك والمباح. كما أنه لو تحقق به الاخذ - الذي سبق أنه سبب الملك - كان المالك هو الغاصب الاخذ لا صاحب الكلب أو الالة المغصوب منه. نعم يستحق المغصوب منه على الغاصب اُجرة العين المغصوبة التي يتحقق بها الصيد والاخذ.
الفصل الثاني
في صيد ما ليس له نفس سائلة
لما كانت ميتة ما ليس له نفس سائلة طاهرة فلا أثر لتذكيته إلا حل أكله. وحيث يختص ما يحل أكله من غير ذي النفس بالسمك والجراد، فالكلام في المقام إنما هو في تذكيتهما من أجل حل أكلهما فعل.
(مسألة ٤١): ذكاة السمك صيده بأخذه والاستيلاء عليه مع خروجه من الماء حياً سواء كان أخذه قبل خروجه من الماء أم كان خروجه من الماء قبل أخذه. فالاول كما إذا ألقى الصائد شبكة فدخلها السمك ثم أخرجه بها أو نصب شبكة أو صنع حظيرة فدخلها السمك ثم نضب الماء عنه وهو حي. والثاني كما إذا نضب الماء عن السمك من دون صيد أو وثب السمك خارج الماء ثم أخذه شخص قبل أن يموت.
(مسألة ٤٢): إذا نضب الماء عن السمك من دون أن يستولي عليه أحد وهو في الماء فاضطرب خارج الماء إلى أن مات لم يحل حتى لو كان عنده من ينظر إليه، إلا أن يأخذه أو يستولي عليه قبل أن يموت. وكذا إذا وثبت السمكة من الماء إلى الشط أو السفينة، فإنها لا تحل إلا أن تؤخذ وهي حية، ولو بأن يسير بالسفينة ناوياً الاستيلاء على السمك الذي وقع فيه. نعم لو جعلت السفينة في مكان من أجل أن يثب فيها السمك كان وثوبه فيها حينئذٍ أخذاً له، نظير دخوله في الحظيرة التي تجعل لصيد السمك.
(مسألة ٤٣): إذا صيد السمك وهو في الماء بالشبكة أو الحظيرة أو نحوهم، ثم نضب عنه الماء أو اُخرج منه، وقد مات بعضه في الماء حرم الميت منه، وحل الباقي. ومع الشك في أن موته كان وهو في الماء أو بعد خروجه منه،
فإن علم زمان خروجه من الماء وشك في زمان موته حل ظاهر، وإلا حرم.
(مسألة ٤٤): إذا اُخرج السمك من الماء حي، ثم اُرجع إليه فمات فيه حرم، فإذا اضطر صاحبه لارجاعه للماء فليكن ذلك بعد موته ولو بأن يقتله هو بضرب أو غيره. أما إذا مات بعد ذلك خارج الماء فهو حلال وإن لم يخرجه بل خرج بنفسه أو نضب الماء عنه، لانه يكفي في تذكية إخراجه في المرة الاُولى.
(مسألة ٤٥): يجوز صيد السمك بإلقاء السم له - المعروف عندنا بالزهر - في الماء. لكن لا يحل السمك به حتى يخرجه الانسان من الماء حي، سواء كان المخرج له هو الذي ألقى السم أم غيره. ولا يكون السمك ملكاً لملقي السم، بل لمن استولى على السمك وأخذه.
(مسألة ٤٦): لا يشترط في حلّ السمك إذا ذكي بإخراجه من الماء حياً أن يموت بنفسه خارج الماء، فلو مات بالتقطيع أو بشق بطنه أو بضربه على رأسه أو غير ذلك حلّ أيض. بل الظاهر جواز أكله حي، كما إذا ابتلع السمك الصغار وهي أحياء.
(مسألة ٤٧): إذا قطعت السمكة قبل أن تذكى، فإن صدق على القطعة أنها سمكة ناقصة، كما لو قطع ذيلها وحده أو مع قسم قليل من أسفل بدنه، حلت بالتذكية بالنحو المتقدم، وإلا لم تحل كالرأس وحده أو مع قليل من البدن، وكأسفل البدن. وفي البدن بتمامه من دون رأس إشكال، والأحوط وجوباً اجتنابه. أما إذا ذكيت تامة ثم قطعت واُرجعت إلى الماء فما لم يمت منها في الماء حلال، وما مات منها في الماء حرام، حتى لو لم يصدق عليه أنه سمكة ناقصة على الأحوط وجوب.
(مسألة ٤٨): إذا ابتلعت السمكة سمكة اُخرى فصيدت بالوجه المتقدم حلت هي والسمكة التي في جوفه.
(مسألة ٤٩): الظاهر أن تذكية السمك بالوجه المتقدم لا تختص بما
يحل أكله، بل تجري فيما يحرم أكله. نعم في جريانها في غير السمك من حيوان الماء إشكال، خصوصاً ما كان منه يعيش في البر أيضاً كالسلحفاة والسرطان والضفدع. بل الظاهر عدم تذكيته بذلك.
(مسألة ٥٠): صيد الجراد وتذكيته بأخذه حي، فإن مات قبل ذلك فهو ميتة حرام الاكل.
(مسألة ٥١): لا يحلّ الدب، وهو الجراد قبل أن يستقل بالطيران.
(مسألة ٥٢): إذا اشتعلت نار أو اُشعلت في موضع فيه جراد فاحترق لم يحل أكله، وكذا إذا أوجبت هيجان الجراد من موضع آخر وسقوطه فيها فاحترق، سواءً كان القصد من أشعالها مجيء الجراد المذكور، أم كان الغرض منه أمراً آخر فصادف مجيء الجراد لها واحتراقه به.
(مسألة ٥٣): يجوز أن يشوى الجراد والسمك بعد صيدهما وتذكيتهما قبل أن يموت، ولا يحرمان بذلك.
(مسألة ٥٤): لا يشترط في تذكية السمك والجراد وصيدهما التسمية.
(مسألة ٥٥): لا يشترط في تذكية السمك والجراد وصيدهما إسلام الآخذ لهم، فيصح صيد الكافر لهما بأقسامه ذمياً كان أو حربي، كتابياً أو غيره.
(مسألة ٥٦): لا بأس بصيد الصبي والمجنون للسمك والجراد إذا تحقق منهما قصد الاخذ والاستيلاء على ما يصيدانه.
(مسألة ٥٧): لا يحكم بتذكية ما يؤخذ من يد الكافر من السمك والجراد إذا شك في تذكيته حتى إذا أخبر بتذكيته ولم يكن متّهماً إذا لم يوجب خبره العلم. نعم إذا أخبر بأخذه له من المسلم صدق في خبره إذا لم يكن متّهم، وحكم بتذكية ما يؤخذ منه لسبق يد المسلم عليه. وهكذا الحال في جميع ما يؤخذ من الكافر مما لا يحل إلا بالتذكية، وقد تقدم في مبحث نجاسة الميتة الفروع المناسبة للمقام. فراجع.
الباب الثاني
في الذبح
ومحل الكلام هو الذبح الموجب للتذكية الذي يترتب عليه طهارة الحيوان وجواز أكله وبيعه وغير ذلك. والكلام فيه يقع في ضمن فصول..
الفصل الأول
فيما يقبل التذكية
(مسألة ٥٨): كل حيوان محلل الاكل قابل للتذكية. فإن كان له نفس سائلة كان قابلاً للتذكية بالذبح، وبعضه يقبل التذكية بالصيد، كما سبق. وإن لم يكن له نفس سائلة - وهو السمك والجراد - فلا يقبل التذكية بالذبح، بل بالصيد لا غير كما تقدم.
(مسألة ٥٩): ما ليس له نفس سائلة إذا كان محرم الاكل فإن كان سمكاً فقد سبق تذكيته بالصيد، وإن لم يكن سمكاً - كالضفدع والوزغ - فهو لا يقبل التذكية لا بالذبح ولا بالصيد. لكن بعد حرمة أكل الحيوان على كل حال، والاحتياط الوجوبي بعدم استصحاب أجزائه في الصلاة إذا كان له لحم، وطهارة ميتته لا يظهر الاثر لعدم تذكيته إلا في وجوب الاحتياط بعدم بيعه.
(مسألة ٦٠): لا تقع التذكية على نجس العين.
(مسألة ٦١): تقع التذكية بالذبح على ما لا يؤكل لحمه من ذي النفس
سواءً كان له جلد يمكن الانتفاع به بلبس وفرش ونحوهما أم ل، وسواءً كان من السباع أم من الطير أم من الحشرات التي تسكن باطن الارض - كالضب وابن عرس - أم من غيرها كالارنب. فيطهر بالذبح لحمها وجلدها ويجوز بيعه.
الفصل الثاني
في الذابح
(مسألة ٦٢): يشترط في الذابح الاسلام، فلا تصح ذبيحة الكافر وإن كان ذمي، حتى إذا علم أنه قد سمى على ذبيحته.
(مسألة ٦٣): تحل ذبيحة المخالف إلا أن يكون محكوماً بالكفر. نعم هي مكروهة.
(مسألة ٦٤): تحل ذبيحة الصبي إذا كان مميزاً يحسن التذكية. نعم لابد من أن يكون معلناً للاسلام، أو يكون محكوماً بأنه مسلم لكون أحد أبويه مسلم. نعم إذا كان معلناً بالكفر فالظاهر عدم حل ذبيحته وإن كان أحد أبويه مسلم.
(مسألة ٦٥): تحل ذبيحة ولد الزنا إذا كان معلناً للاسلام وإن كان صبي. بل الظاهر كفاية كون أحد أبويه مسلماً في الحكم بإسلامه وإن كان صبياً لم يعلن الاسلام، وكذا إذا كان تابعاً لمسلم. على ما تقدم في مطهرية التبعية من كتاب الطهارة.
(مسألة ٦٦): تحلّ ذبيحة المرأة والاعمى والأغلف والخصي والجنب والحائض والفاسق.
(مسألة ٦٧): تحل ذبيحة ناقص العقل إذا كان مميزاً يتأتى منه قصد الذبح المشروع، أما إذا لم يتحقق منه ذلك - كما في المجنون الصّرف - فلا يصح. وكذا الحال في السكران، فإن سكره قد لا يمنع من تمييزه وقصده الذبح الشرعي
بالوجه الذي يترتب عليه الاثر عند العقلاء، بخلاف النائم، فإن الظاهر عدم العبرة بقصده.
(مسألة ٦٨): لا بأس بتعدد الذابح، بأن يتولى الذبح اثنان - مثلاً - على سبيل الاشتراك مقترنين بأن يأخذا السكين معاً ويذبحا مع، أو يأخذ كل منهما سكيناً ويقطع أحدهما بعض الاعضاء والآخر الباقي دفعة واحدة. أو يكون ذلك منهما على التعاقب فيقطع أحدهما بعض الاعضاء ثم يقطع الآخر الباقي. ومن ذلك ما إذا ذبح شخص الحيوان وتركه فظهر النقص في ذبحه فأخذه الآخر وأتم ذبحه. ولابد من تسمية الكل.
(مسألة ٦٩): لا بأس بذبيحة المكره وإن لم يكن إكراهه بحق.
(مسألة ٧٠): لا بأس بذبيحة من لا يعتقد بوجوب التسمية أو يعتقد بعدم وجوبها إذا سمى.
(مسألة ٧١): تحل ذبيحة المعتدي والغاصب للحيوان المذبوح أو لالة الذبح وإن كان آثماً في ذبحه. ومثله ما إذا كان الحيوان منذوراً مثلاً لوجه خاص فذبح على وجه آخر. فالشاة التي ينذر صاحبها - مثلاً - أن يضحي بها لو ذبحت في غير وقت الاُضحية عمداً أو جهلاً أو نسياناً تذكى بالذبح ويحل أكله.
الفصل الثالث
في كيفية الذبح
(مسألة ٧٢): لابد في الذبح من قطع الاعضاء الاربعة، وهي مجرى النفس - الذي قد يسمى بالحلقوم - ومجرى الطعام والشراب - الذي قد يسمى بالمريء - والوَدَجَان، وهما عرقان محيطان بهما يجري فيهما الدم، ولا يكفي شق شيء منها من دون قطع.
(مسألة ٧٣): الظاهر أن قطع الاعضاء المذكورة يتوقف على بقاء (الجوزة) في جانب الرأس، فلو بقي منها شيء في الجسد لم يتم الذبح المذكي، لأن الحلقوم والمريء يبدءان منه، فمع بقاء شيء منها في جانب الرأس يكون موضع الذبح قبلهم، ولا يقطعان حينئذٍ.
(مسألة ٧٤): إذا قطع بعض الاعضاء الاربعة من تحت الجوزة على غير الوجه الشرعي - كما إذا استند إلى افتراس سبع أو ضرب لا يقصد به التذكية أو غير ذلك - لم يكف في التذكية قطع الباقي، بل يحرم الحيوان. نعم إذا شق بعض الاعضاء أو كلها من دون قطع وبقي الحيوان حياً أمكن تذكيته بقطعها من محل الشق أو من فوقه أو تحته.
(مسألة ٧٥): إذا أخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة أو من بعضها أمكنه التدارك ما دام الحيوان حياً فإذا ذبحه من تحت الجوزة ذكي وحل لحمه.
(مسألة ٧٦): لا يجب التتابع العرفي في قطع الاعضاء، فلو قطع بعض الاعضاء من الحيوان فأرسله أو أفلت ثم قبض عليه فقطع الباقي وهو حي ذكي الحيوان وحلّ لحمه.
(مسألة ٧٧): لا يجب في الذبح أن يكون في أعلى الرقبة تحت الجوزة مباشرة، بل يجوز أن يكون أسفل من ذلك إذا تحقق قطع الاعضاء الاربعة.
(مسألة ٧٨): لا يصح الذبح من القف، حتى لو قطعت الاعضاء الاربعة بأن يبدأ من القفا وينتهي بالحلقوم. بل الأحوط وجوباً وضع السكين في ظاهر الرقبة والنزول بها إلى الباطن، ولا يقلب السكين ويدخلها وسط الرقبة تحت الاعضاء ويخرجها إلى الظاهر.
(مسألة ٧٩): الأحوط وجوباً عدم قطع رأس الحيوان عند الذبح، لكن لو حصل ذلك غفلة أو خطأ أو لاسراع السكين لم يحرم الحيوان المذبوح، بل ل
يحرم حتى لو تعمد ذلك، وإن كان الأحوط استحباباً الترك. ويجري جميع ذلك في النخع الذي هو عبارة عن الوصول بالسكين للنخاع فيقطع قبل أن يموت الحيوان من دون أن يقطع الرأس.
(مسألة ٨٠): يشكل الاكتفاء بقطع الاعضاء الاربعة بنحو القرض بمثل (المقص) و(المقراضة) ونحوهما مما يقطع بجمع الالتين المحددتين لا بإمرار آلة واحدة كالسكين. نعم لا بأس به مع الاضطرار. والمعيار فيه خوف موت الحيوان لو تأخر ذبحه إلى حين القدرة على مثل السكين.
(مسألة ٨١): تختص الابل من بين البهائم بأن تذكيتها بالنحر، ولا يجوز ذلك في غيره، حتى الخيل على الأحوط وجوب. فإن ذبحت الابل لم تذك ولم تحل، إلا أن تنحر قبل أن تموت، وإن نحر غيرها لم يذك ولم يحل إلا أن يذبح قبل أن يموت.
(مسألة ٨٢): كيفية النحر أن يطعن الحيوان بالالة - من سكين أو حربة أو غيرهما حتى مثل المزرف والمنجل - في اللبة، وهي الموضع المنخفض في أصل العنق عند وسط أعلى الصدر.
(مسألة ٨٣): إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره جاز تذكيته في غير موضع التذكية بالنحو المتيسر، وحل أكل لحمه. سواءً كان ذلك لاستصعابه وشروده أم لصيرورته في مكان لا يسيطر عليه فيه المذكي، كما لو تردَّى في بئر أو سقط عليه البناء أو نحو ذلك. نعم لابد من تحقق شروط التذكية الاُخرى عدا الاستقبال. كما أنه إذا أدرك ذكاته بعد جرحه أو عقره وجبت تذكيته كالصيد.
(مسألة ٨٤): الجنين إذا ماتت اُمه من دون تذكية فإن استخرج منها حياً واُدركت ذكاته وذكي حلَّ، وإلا كان ميتة محرم. وكذا إذا استخرج من اُمه وهي حية بعملية قيصرية أو نحوها فإنه يحل إذا ذكي بالذبح ، ولا يحل بدون ذلك.
(مسألة ٨٥): الجنين إذا ذكيت اُمه فمات في بطنها قبل أن يستخرج منها كانت ذكاتها ذكاة له فيحل أكله، وكذا إذا لم تلجه الروح في بطنه.
(مسألة ٨٦): الجنين إذا ذكيت اُمه فاستخرج منها حياً لم يحل إلا بالتذكية، فإن مات قبل أن يذكى فهو ميتة حرام، سواءً ضاق الوقت عن تذكيته أم وسعها ولم يذك تسامحاً أو غفلة.
(مسألة ٨٧): تجب المبادرة بالنحو المتعارف إلى سلخ الذبيحة ثم شق بطنها لآخراج الجنين منها وإدراك تذكيته، فلو لم يبادر بالنحو المتعارف واحتمل موت الجنين بسبب ذلك حكم بعدم ذكاة الجنين وبحرمته. نعم لو علم بعدم إدراكه حياً على كل حال لم تجب المبادرة لآخراجه، وحل حينئذٍ.
(مسألة ٨٨): إنما يجوز أكل الجنين إذا كان تام الخلقة وقد نبت شعره، وإلا لم يحل، سواء ذكي بذكاة اُمه أم بذبحه بنفسه.
(مسألة ٨٩): لا فرق في تذكية الجنين بذكاة اُمه بين محلل الاكل ومحرمه.
الفصل الرابع
في شروط الذبح
وهي اُمور..
الأول: القصد للذبح أو النحر، فلا تحصل التذكية بالذبح أو النحر من غير القاصد، كما لو وقع السكين من يده على الاعضاء الاربعة فقطعه، أو قصد بتحريك السكين أمراً غير الذبح فقطعت الاعضاء الاربعة، وعلى ذلك يبتني ما تقدم من عدم صحة الذبح والنحر من غير المميز، كالمجنون والنائم.
الثاني: أن يكون الذبح أو النحر بالحديد فلا يصح بغيره وإن كان من
الفلزات الصلبة، كالنحاس والذهب والفضة. هذا مع تيسر الحديد، أما مع تعذره فيجوز الذبح بكل ما يفري الاوداج، كالفلزات الاُخرى والزجاج والعظم والخشب وغيره. وكذا الحال في النحر.
(مسألة ٩٠): يكفي في جواز الذبح بغير الحديد تعذر الحديد حين إرادة الذبح، ولا يشترط الاضطرار للذبح للحاجة للحم أو لخوف موت الحيوان.
(مسألة ٩١): يذكر بعض أهل الخبرة أن الستيل حديد مصفى مشتمل على خليط من مواد اُخرى. كما يذكرون أيضاً أن الحديد المتعارف مشتمل على مواد اُخرى. وحينئذٍ إذا كانت نسبة الخليط في الستيل تقارب نسبة الخليط في الحديد المتعارف فلا بأس بالذبح به ولعل ذلك هو الغالب من أنواع الستيل.
(مسألة ٩٢): الذبح بالسن والظفر - عند تعذر الذبح بالحديد - إن كان بإمرار أحدهما على الاعضاء نظير إمرار السكين فالظاهر جوازه، وإن كان بنحو القرض - كما لو قطعت الاعضاء بالعض أو بجمع الظفرين عليها - أشكل جوازه، لما سبق في الفصل الثالث من الاشكال في قطع الاعضاء بنحو القرض. نعم مع الاضطرار لعدم تيسر الذبح إلا بهذا الوجه وخوف موت الحيوان فلا بأس به، كما تقدم.
الثالث: الاستقبال بالذبيحة بأن توجه للقبلة بمقاديمها ومذبحه، فإن ذبحت نائمة وجهت إلى القبلة معترضة، لكن لا تطرح على قفاه، بل تضجع على جانبها الايمن - بأن يكون رأسها إلى يمين المستقبل، كهيئة الميت حال الدفن - أو على جانبها الايسر - بأن يكون رأسها إلى يسار المستقبل - ليكون مذبحها موجهاً للقبلة.
وإن ذبحت جالسة أو قائمة وجهت بصدرها إلى القبلة، كما هو الحال في الابل حال النحر.
(مسألة ٩٣): يجوز ذبح الحيوان معلقاً من رجليه أو من رأسه. ويكون الاستقبال به بتوجيه صدره وبطنه إلى القبلة.
(مسألة ٩٤): إذا لم يستقبل الذابح أو الناحر بالحيوان القبلة عالماً عامداً لم يذكه الذبح وحرم أكله، وإن كان ناسياً أو جاهلاً بوجوب الاستقبال ذكاه الذبح وحل أكله، وكذا إذا كان مخطئاً في القبلة بأن وجهها لجهة اعتقد أنها القبلة فتبين الخلاف.
(مسألة ٩٥): إذا جهلت القبلة ولم يتيسر معرفتها قريباً سقط اعتبار الاستقبال، وكذا إذا تعذر الاستقبال لاستصعاب الحيوان أو لخوف موته لو صرف الوقت في توجيهه للقبلة.
(مسألة ٩٦): لا يشترط استقبال الذابح، وإن كان أحوط استحباب.
الرابع: التسمية ممن يباشر الذبح أو النحر أو غيرهما مما يقوم مقامهما عند تعذرهما ولا تجزئ التسمية من غير الذابح، وأظهر في عدم الاجزاء التسمية في المسجل أو نحوه مما يحكي الصوت من دون ان ينطق بها إنسان.
(مسألة ٩٧): لابد من مقارنة التسمية عرفاً للذبح أو النحر أو ما يقوم مقامهم، ولا تجزئ التسمية عند الشروع في المقدمات كسحب الحيوان وربطه وإضجاعه.
(مسألة ٩٨): إذا نسي المذكي التسمية حلت ذبيحته، بخلاف ما لو تركها عمداً ولو بسبب الجهل باشتراطه، نظير ما تقدم في الصيد. وتقدمت هناك فروع اُخرى في التسمية تجري هن.
(مسألة ٩٩): يستحب عند الذبح الصلاة على النبي وآله صلوات الله عليهم.
(مسألة ١٠٠): من نسي التسمية عند الذبح أو النحر استحب له التسمية متى ذكر، يقول: بسم الله على أوله وعلى آخره. وإن لم يفعل تأكد استحباب التسمية حين الاكل من لحم الحيوان المذبوح.
الخامس: حياة الحيوان حين الذبح على النحو المتقدم في إدراك الذكاة في الصيد.
السادس: خروج الدم المعتدل على النحو المتعارف عند ذبح ذلك الحيوان فإن خرج متثاقلاً لم يذك وحرم أكله وإن علم بحياته حين الذبح.
السابع: حركة الذبيحة بعد الذبح ولو يسير، كما لو تحركت رجلها أو عينه.
(مسألة ١٠١): لا يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة، بمعنى أن يعيش مثلها اليوم والايام، بل يكفي في إدراك ذكاتها حياتها حين الذبح، كما سبق في الشرط الخامس. وعلى هذا لو طرأ عليها ما من شأنه أن يقضي عليها - من جرح أو عقر أو كسر أو غير ذلك - وذبحت بالشروط المتقدمة ذكيت وحلت، بل لو شقت بطنها وخرجت حشوتها ثم ذبحت حلت. وكذا إذا حصل ذلك مقارناً للذبح. نعم لو قطع رأسها وانفصل من فوق المذبح، ففي حل جسدها بقطع الاعضاء الاربعة بالشروط المتقدمة إشكال، والاظهر العدم. وأما الرأس فلا إشكال في عدم حله بذلك. وكذا سائر الاعضاء المنفصلة قبل الذبح - كالرجل والإلية - فإنها لا تذكى ولا تحل بذبح الحيوان إذا كان بعد فصلها منه.
(مسألة ١٠٢): إذا تم ذبح الحيوان بشروطه المتقدمة ثم حصل له قبل موته ما يوجب الموت - كما لو وقع في ماء أو نار أو سقط إلى الارض من شاهق أو نحو ذلك - لم يمنع ذلك من تذكيته بالذبح وحل أكله، بخلاف الصيد فإنه لا يحكم بتذكية الحيوان به إلا أن يعلم استناد موت الحيوان إليه، كما تقدم. نعم يكره هنا أكل الحيوان، بل الأحوط استحباباً تركه.
(مسألة ١٠٣): إذا قطع من الحيوان شيء بعد ذبحه قبل موته لم يحرم. وإن كان الاولى ترك ذلك، لاحتمال كونه سبباً لايذائه. بل قيل بكراهة قطع شيء منه قبل أن يبرد.
(مسألة ١٠٤): سلخ الذبيحة بعد إكمال ذبحها وقبل موتها لا يوجب حرمته. نعم هو مكروه، بل قيل بكراهة سلخها قبل أن تبرد.
(مسألة ١٠٥): قد ذكر للذبح والنحر آداب، فيستحب في ذبح الغنم ربط يدي الحيوان ورجل واحدة، ثم يمسك صوفه أو شعره بعد ذبحه حتى يبرد. وفي ذبح البقر ربط اليدين والرجلين وإطلاق الذنب، وفي الابل أن تنحر قائمة مع ربط يد واحدة، والاولى أن تكون اليسرى، فإن نحرت باركة ربطت يداها ما بين الخف إلى الركبة. ويستحب إرسال الطير بعد الذبح.
(مسألة ١٠٦): يستحب أن يساق الحيوان للذبح برفق، ويعرض عليه الماء قبل الذبح. وأن تحدّ السكين ويسرع في الذبح ليكون أسهل. وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «إن الله تعالى شأنه كتب عليكم الاحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته».
(مسألة ١٠٧): تكره الذباحة ليل، وكذا في نهار الجمعة إلى الزوال. وأن يذبح الانسان بيده ما ربّاه من النعم. وأن تذبح الشاة عند الشاة والجزور عند الجزور، بل الاولى العموم، فلا يذبح الحيوان عند حيوان ينظر إليه وإن لم يكن من جنسه. كما يكره أن يري الحيوان السكين عند إرادة ذبحه.
(مسألة ١٠٨): إذا شك في التذكية حكم شرعاً بعدمها إلا بحجة شرعية. وقد تقدم في مبحث نجاسة الميتة أن يد المسلم حجة على التذكية، وتقدم جملة من الفروع المتعلقة بذلك فلا نطيل بإعادته.
والحمد لله رب العالمين
كتاب الأطعمة والأشربة
وفيه فصول:
الفصل الأول
في حيوان البحر
(مسألة ١): لا يحل من حيوان البحر إلا ما له قشر. والمراد بالقشر الصدف الذي يكسو الحيوان ويمكن أن ينفصل عنه، كفلس السمك، وقشر الاربيان الذي يعرف في عصورنا بالروبيان وغيرهم. أما الصدف اللازم للحيوان الملتصق به - كصدف السلحفاة والسرطان والمحار - فلا يكفي في تحليله.
(مسألة ٢): إذا شك في أن للحيوان قشر أو لا حرم أكله. نعم بعض السمك الذي له قشر كثيراً ما يحتك ببعض الاشياء فيسقط قشره، ولذا يبقى عليه شيء من القشر في بعض المواضع التي لا يصلها الحك ويراها الفاحص بالتأمل. وقد تضمنت ذلك الاخبار في سمك أطلقت عليه اسم الكنعت. وأكده في زماننا بعض المستفتين. وعن بعضهم تأكيد ذلك في نوعين من السمك يطلق عليهما (الصافي) و(المزلق). وعلى كل حال فما كان من هذا النوع من السمك حلال. وينبغي التأكد منه.
(مسألة ٣): إذا أخبر من عنده السمك بأن لذلك السمك قشر، أو أنه من النوع الذي له قشر أخذ بقوله إذا لم يكن متهم.
(مسألة ٤): لا يجوز بيع السمك المحرم الاكل على من يستحله أو على من يبيعه ممن يستحله، إلا أن يكون له منفعة محللة معتد بها غير الاكل، وقد سبقت بعض الفروع المناسبة بذلك في مبحث المكاسب المحرمة.
(مسألة ٥): إذا ابتلعت الحية سمكة ثم ألقتها وقد تسلخت فلوسها فالأحوط وجوباً عدم أكله. أما إذا لم تتسلخ فلوسها فيحل أكلها إذا كانت ذكية، أو ذكيت بعد ذلك بأن اُخذت وهي حية.
(مسألة ٦): بيض السمك تابع للسمك الذي يكون فيه، فإن كان محرماً حرم بيضه، وإن كان حلالاً حل بيضه. وإذا اشتبه حال البيض، وشك في أنه من السمك الحلال أو الحرام حرم أكله.
الفصل الثاني
في حيوان البر
(مسألة ٧): يحرم أكل لحم الانسان.
(مسألة ٨): يحرم من حيوان البر كل ذي ناب، وكل سبع وإن لم يكن له ناب. والمراد بالسبع ما يفترس الحيوان، ويأكل اللحم قوياً كان كالاسد والنمر والذئب، أو ضعيفاً كالضبع والثعلب والسنور.
(مسألة ٩): يحرم من الحيوان المسوخ. وقد ورد في الكتاب المجيد والاخبار الكثيرة أن الله تعالى مسخ جماعات من الناس قد عتوا وتمّردوا على صور بعض الحيوانات. كما ورد أن المسوخ قد هلكت ولم تتناسل، وأن التحريم إنما هو لما مثلت به من الحيوان. وقد عدّ منها من حيوان البر غير السباع: الخنزير والقرد والفيل والدب والارنب والضب والفأرة والعقرب والوزغ.
(مسألة ١٠): يحرم أكل الحشرات كالخنافس والديدان والنمل والقمل وغيره.
(مسألة ١١): يحرم كلما يسكن باطن الارض من صغار الحيوانات كالقنفذ وابن عرس والجرذ واليربوع والحية وغيره.
(مسألة ١٢): يحل لحم النعم الثلاثة: الابل - العراب وهي ذات السنام الواحد، والبخاتي وهي ذات السنامين - والبقر - ومنه الجاموس - والغنم الضأن والمعز.
(مسألة ١٣): يحل لحم الخيل والبغال والحمير، على كراهة في الجميع وتشتد في الاخيرين.
(مسألة ١٤): يحل من الحيوان الوحشي البقر والكباش الجبلية والحمركحمار الزرد - والظباء واليحامير - التي هي نوع من الايل - بل جميع أنواع الايل، والوعل، وما يسانخ ذلك عرف. وفي اختصاص الحل بذلك إشكال.
الفصل الثالث
في الطير
(مسألة ١٥): يحرم السبع من الطير، وهو ما يفترس، ويأكل اللحم، كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق والنسر والحدأة وغيره. وليس منه طير الماء الذي يأكل السمك.
(مسألة ١٦): يحرم من الطير ما يغلب في طيرانه الصفيف، ويحل منه ما يغلب في طيرانه الدفيف والخفوق.
(مسألة ١٧): إذا لم يعلم كيفية طيران الطير أو شاع في طيرانه الصفيف
والدفيف مع، فإن لم يكن له حوصلة ولا قانصة ولا صيصية فهو محرم الاكل. والظاهر أن الحوصلة مجمع الحب للطائر الذي يكون في آخر العنق، والقانصة هي العضلة الصلبة التي يهضم بها الطعام، فبعض الطيور له قانصة، وبعضها له معدة كمعدة الانسان وكثير من الحيوانات. أما الصيصية فهي الشوكة التي خلف ساق الطائر خارجة عن الكف.
(مسألة ١٨): اللقلق وإن قيل أن له حوصلة وقانصة وصيصية، إلا أن الظاهر حرمته، لأن الغالب في طيرانه الصفيف.
(مسألة ١٩): يحرم من الطير الخفاش - ومنه الوطواط - والطاووس، والغراب بجميع أنواعه.
(مسألة ٢٠): يحرم من الطير ما كان من سنخ الحشرات كالزنبور والنحل والذباب ونحوه، ولا يحل من هذا السنخ إلا الجراد.
الفصل الرابع
فيما يحرم بالعرض
وهو اُمور..
الأول: الجلال، وهو الذي يتغذى على عذرة الانسان لا يختلط معها غيره. أما إذا كان يختلط معها غيرها فليس هو من الجلال المحرم، إلا أن يكون ذلك نادراً لا يعتد به عرفاً بحيث لا يمنع من صدق أن غذاءه العذرة، فيحرم. كما لابد في صدق الجلال من تغذيه بالعذرة مدة معتداً بها عرف، بحيث يصدق عرفاً أن غذاءه العذرة. ولا يفرق في ذلك بين أنواع الحيوان حتى السمك.
(مسألة ٢١): يرتفع الجلل والتحريم عن الحيوان باستبرائه ومنعه عن
العذرة مدة معتداً به. وقد تقدم في العاشر من المطهرات من مباحث الطهارة من الخبث تحديد مدة الاستبراء، فلا نطيل بإعادته. نعم لم يتقدم منا التعرض لاستبراء السمك. والظاهر أنه يكفي فيه منعه من العذرة وتغذيته بغيرها يوماً وليلة.
(مسألة ٢٢): الأحوط وجوباً حرمة نسل الجلال المتكون منه قبل الاستبراء وعدم حله بالاستبراء.
الثاني: الجدي الذي يرتضع من لبن خنزيرة مدة معتد به. والأحوط وجوباً عموم التحريم لغير الجدي من الحيوانات التي ترتضع من لبن الخنزيرة. كما أن الأحوط وجوباً العموم لشرب اللبن من غير ارتضاع.
(مسألة ٢٣): لا يلحق بالخنزيرة غيرها من الحيوانات النجسة كالكلبة والكافرة التي قيل بنجاسته.
(مسألة ٢٤): يستبرأ الحيوان المذكور بحبسه عن الخنزيرة، وإرضاعه من حيوان من سنخه سبعة أيام. وإن كان استغنى عن الرضاع واللبن يعلف علفاً طاهراً سبعة أيام أيض.
(مسألة ٢٥): كما يحرم الحيوان المذكور يحرم نسله المتكون من منيه قبل أن يستبر، ولا يحل النسل حينئذٍ بالاستبراء. وأما إذا كان المرتضع اُنثى ففي حرمة حملها الذي تعلق به قبل الاستبراء إشكال. وإن كان أحوط وجوب.
الثالث: البهيمة التي يطؤها الرجل، قبلاً أو دبراً والأحوط وجوباً العموم في الواطئ لكل ذكر وإن كان صبي، وفي الموطوء لكل حيوان ذكراً كان أو اُنثى مأكولاً أو غيره حتى الطير. بل العموم لنسل الموطوء، فيحرم أيض.
(مسألة ٢٦): إذا كان الحيوان ميتاً مذكى حلال اللحم لم يحرم بالوطء، ولا تجري عليه الاحكام الاُخرى للموطوء. كما لاتجري الاحكام المذكورة إذا كان الميت حرام اللحم أو غير مذكى.
(مسألة ٢٧): ما يحرم لكونه موطوءاً أو نسلاً لموطوء ليس له استبراء يحلله.
(مسألة ٢٨): إذا كان الموطوء مما يطلب لحمه ذبح، فإن مات اُحرق. وإذا كان الواطئ غير المالك اُغرم قيمته للمالك.
(مسألة ٢٩): إذا كان الحيوان الموطوء مما يطلب ظهره للركوب ولا يطلب لحمه - كالحمار - اُخرج إلى مدينة اُخرى لا يعرف فيها الواطئ، فيباع هناك. وحينئذٍ إن كان الواطئ غير المالك اُغرم قيمته للمالك في المدينة التي وطئ فيه، وتحمل هو نفقة إخراجه وأخذ هو ثمنه بعد بيعه في المدينة الاُخرى. وإن كان الواطئ هو المالك تحمل هو نفقة الآخراج وكان له الثمن بعد البيع. والأحوط وجوباً جريان ذلك فيما يحرم أكل لحمه ولا يطلب ظهره للركوب.
(مسألة ٣٠): إذا اشتبه الموطوء بغيره فيمايؤكل لحمه ويطلب اُخرج بالقرعة.
(مسألة ٣١): إذا شرب الحيوان الذي هو حلال اللحم خمراً لم يحرم لحمه، بل يؤكل بعد أن يغسل على الأحوط استحباب. نعم إذا سكر فذبح حال سكره فالأحوط وجوباً عدم أكل ما في بطنه من القلب والكبد والكرش وغيره. أما لو شرب بولاً أو غيره من المائعات أو أكل نجساً فذبح فإنه يؤكل ما في بطنه بعد غسله وتطهيره من النجاسة مع بقاء عينها وعدم تحلله.
الرابع: الميتة، فإن الحيوان المحلل الاكل إنما يحل بالتذكية، أما إذا صار ميتة - بأن مات من دون تذكيته - فإنه يحرم مطلقاً وينجس إذا كان له نفس سائلة.
(مسألة ٣٢): بحكم الميتة ما يقطع من الحيوان الحي، على تفصيل تقدم في مبحث نجاسة الميتة من مباحث الطهارة من الخبث.
(مسألة ٣٣): يستثنى من نجاسة الميتة ما لا تحله الحياة منه، فهو طاهر وحلال إذا كان مما يؤكل أو يشرب كالبيضة والانفحة واللبن، على ما تقدم تفصيل الكلام في مبحث نجاسة الميتة.
الفصل الخامس
في الجامد
(مسألة ٣٤): البيض والانفحة تابعان للحيوان الذي يتكونان فيه، فما كان من الحيوان المحرم الاكل حرام، وما كان من الحيوان المحلل الاكل حلال.
(مسألة ٣٥): إذا اشتبه البيض بين ما يحل أكله وما يحرم أكله أكل ما اختلف طرفاه وترك ما تساوى طرفاه. هذا إذا كان المحتمل هو الحرمة بالاصل. أما إذا كان المحتمل الحرمة بالعرض - كالجلل - فمع الشك في حال البيض والانفحة يحكم بحليته إلا مع العلم الاجمالي بوجود الحرام فيه فيجتنب الكل. أما الانفحة فإنها مع الاشتباه محكومة بالحل،إلا مع العلم الاجمالي بوجود الحرام فيحرم الكل.
(مسألة ٣٦): يحرم من الذبيحة التي يحل أكلها الفرث والدم والقضيب والاُنثيان والغدد والطحال. والأحوط وجوباً اجتناب الرحم والحياء - وهو فرج الاُنثى - والعلباء - وهي العصبتان خلف الرقبة - والنخاع - وهو المخ الابيض المستطيل في فقار الظهر - والمثانة والمرارة. والأحوط استحباباً اجتناب الحدق والخرز التي في الدماغ. ويكره الكليتان واُذنا القلب.
(مسألة ٣٧): لا فرق في تحريم الاُمور المذكورة بين الحيوان الصغير والكبير. نعم لابد من أن يكون لها فيه وجود عرفي متميز ملتفت إليه، فلو كانت خفية مغفولاً عنها لصغرها لم تحرم، كما في جملة من هذه الاُمور في الحيوانات الصغيرة، وكالغدد الدقيقة في الحيوان الكبير.
(مسألة ٣٨): لا تحرم هذه الاُمور في السمك ونحوه مما لا يذكى بالذبح.
نعم في جواز أكل أو شرب دم السمك إذا كان له وجود معتد به عرفاً إشكال. والأحوط وجوباً تركه. بل يحرم إذا كان مما لا يؤكل لحمه.
(مسألة ٣٩): يعفى عن الدم القليل المتخلف في العروق الدقيقة ونحوه مما يكون عرفاً تابعاً للحم ومن شؤونه من دون أن يكون له وجود عرفي متميز.
(مسألة ٤٠): تحرم الاعيان النجسة كالعذرة، وكذا المتنجسة إذا لم تطهر.
(مسألة ٤١): يحرم أكل الطين. والأحوط وجوباً إلحاق التراب والرمل ونحوهما مما هو من سنخ الارض به. أما بقية المعادن فلا تحرم، إلا أن تكون سبباً في ضرر يحرم إيقاعه بالنفس.
(مسألة ٤٢): يستثنى من حرمة أكل الطين طين قبر الحسين (عليه السلام) ، فإنه يجوز أكله بنية الاستشفاء. ويقتصر على القليل منه بما لا يزيد على مقدار الحمصة. وفي إلحاق طين قبور بقية المعصومين (عليهم السلام) بها إشكال، والاظهر العدم.
(مسألة ٤٣): يجوز الاستشفاء بالطين المأخوذ من مسافة ميل من قبر الحسين (عليه السلام) من جميع الجوانب. ويجوز أكله لذلك. وأفضله ما يؤخذ من مربع سعته سبعون باعاً في سبعين باعاً يتوسطه القبر الشريف. يقارب مربعاً سعته مائة وعشرون متراً في مائة وعشرين متر. وأفضل ذلك ما يؤخذ من عند الرأس الشريف وإن صار متعذراً في زمانن.
هذ، وقد ورد في بعض الاخبار أنه يستشفى بما بينه وبين القبر الشريف أربعة أميال، وحيث لم تتم عندنا حجية الخبر المذكور فلا مجال للاستشفاء بذلك بأكله. نعم لا بأس بالاستشفاء به برجاء الشفاء بوجه غير الاكل ولو بوضعه في ماء حتى يستهلك ثم يشرب الماء.
(مسألة ٤٤): الأحوط وجوباً الاجتناب عن المستقذرات من إفرازات الانسان والحيوان المحلل فضلاً عن المحرم وإن لم تكن نجسة.
(مسألة ٤٥): الظاهر جواز أكل المواد المحروقة، كالخبز واللحم وغيرهم.
الفصل السادس
في المائع
(مسألة ٤٦): يحرم الخمر وكل مسكر، وإن كان جامد. وتختص النجاسة بالمائع بالاصل، نعم يطهر ويحل إذا انقلب خل، وقد تقدم تفصيل ذلك في مباحث الطهارة من الخبث.
(مسألة ٤٧): يحرم الفقاع وهو نجس، كما تقدم.
(مسألة ٤٨): يحرم كل مائع نجس أو متنجس. وقد تقدم تحديد كل منهما في مباحث الطهارة من الخبث.
(مسألة ٤٩): يحرم العصير العنبي إذا غلا بالنار حتى يذهب ثلثاه، وهو الأحوط وجوباً في العصير الزبيبي، والأحوط استحباباً في العصير التمري وقد تقدمت بعض الفروع المتعلقة بذلك عند الكلام في نجاسة الخمر.
(مسألة ٥٠): لا يحرم شيء من أنواع العصير الباقية، ولا شيء من المربيات إذا لم تكن مسكرة وإن شم منها رائحة المسكر.
(مسألة ٥١): اللبن تابع للحيوان الذي يتكون فيه، فيحرم ما كان من حيوان يحرم أكله، ويحل ما كان من حيوان يحل أكله. نعم لبن الانسان حلال.
(مسألة ٥٢): الأحوط وجوباً اجتناب الابوال الطاهرة. نعم يجوز استعمالها للتداوي وإن لم يبلغ مرتبة الضرورة.
(مسألة ٥٣): الظاهر حلية الريق من الحيوان المأكول اللحم. أما من الحيوان غير المأكول اللحم فالأحوط وجوباً اجتنابه إذا كان له وجود معتد به غير مستهلك. نعم يحل ريق الانسان.
الفصل السابع
في بعض الاحكام العامّة
(مسألة ٥٤): يحرم أكل وشرب ما يكون مضراً ضرراً يبلغ حد الخطر والخوف على الحياة، أو على عرض الانسان بحيث يلزم هتكه ووهنه. بل الأحوط وجوباً اجتناب ما يخشى معه من تعطيل إحدى القوى التي أنعم الله تعالى بها على الانسان، إلا لدفع ضرر مساو أو أهم.
(مسألة ٥٥): العادات الضارة - كالتدخين والافيون - لا تحرم إلا أن يبلغ احتمال الضرر حداً يصدق معه الخوف من الضرر المحرم بسبب استعمال الشيء، ولا تحرم بدون ذلك، كما إذا كانت من سنخ المعد والمهيّئ للضرر بحيث لا يترتب عليه الضرر إلا بضميمة اُمور غير معلومة الحصول كطول العمر وحدوث بعض المضاعفات في البدن وغير ذلك. نعم إذا كان من شأن تلك العادة الاستحكام بنحو لا يتخلى صاحبها عنها عادة وكان من شأنها أن تجر للمهالك أو الفضائح فالظاهر حرمة الاقدام عليه. كما لا يحسن بالانسان العاقل أن يخضع نفسه لعادة تسيطر عليه وتستعبده وإن لم تكن ضارة بنفسه.
(مسألة ٥٦): إذا انحصر الدواء بأكل ما هو حرام حل بمقدار الحاجة وإن لم يضطر للتداوي من المرض لعدم كونه مهلك. إلا في المسكر ولحم الخنزير وشحمه وغيرهما من أجزائه، فإنه لا يجوز التداوي بها حينئذٍ. نعم مع توقف الحياة عليه فالظاهر جوازه. ويلزم حينئذٍ التأكد من ذلك.
(مسألة ٥٧): الأحوط وجوباً عدم الاكتحال بالمسكر، إلا مع الاضطرار، لتوقف شفاء العين عليه.
(مسألة ٥٨): يجوز للمضطر بل يجب تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه. ويستثنى من ذلك الباغي والعادي فلا يجوز لهما تناول المحرم وإن لزم التلف. نعم لو تابا وعزما على عدم العود لما هما فيه حل لهما بل وجب عليهما تناول ما يسد الرمق.
(مسألة ٥٩): الباغي هو الخارج على الامام الحق، والذي يخرج للصيد بطراً ولهو، لا لأجل الاكل أو التجارة. والعادي هو قاطع الطريق والذي يخرج لأجل السرقة ممن يحرم السرقة منه. وفي شموله لبقية وجوه العدوان على الغير بوجه محرم - كالذي يخرج لقتل محترم الدم أو هتك عرض محترم العرض - إشكال.
(مسألة ٦٠): إنما يحرم سد الرمق على الباغي والعادي إذا كان البغي والعدوان هما منشأ الاضطرار للحرام، أما إذا كان منشأ الاضطرار عاماً حتى في حال عدم البغي والعدوان فالظاهر عدم حرمة سد الرمق على الباغي والعادي، كما في وقت المجاعة العامة.
(مسألة ٦١): يحرم الاكل والشرب وكل تصرف في مال من هو محترم المال إلا بإذنه أو بإحراز رضاه بالتصرف المذكور. ويستثنى من ذلك من تضمَّنته الآية (٦١) من سورة النور، وهم الاباء والاُمهات والاخوة والاخوات والاعمام والعمَّات والاخوال والخالات ومن يتوكل عن المالك على بيته فيدفع إليه مفتاحه والصديق. ويلحق بهم الزوجة والولد. فيجوز الاكل من بيوتهم مع عدم إحراز الرض. نعم يشكل الاكل مع الظن بعدم الرض، فضلاً عن العلم. وكذا مع عدم إحراز رضا صاحب البيت بالدخول فيه.
(مسألة ٦٢): يقتصر في الاكل على الطعام - كالخبز - والادام - كاللحم المطبوخ - والتمر، دون غير ذلك كالحلوى والمربيات ونحوها مما يؤكل بنفسه من دون أن يكون إدام، فإنه لا يجوز أكلها إلا مع العلم برضا صاحبه.
(مسألة ٦٣): يستثنى من عدم جواز الاكل من مال الغير أكل الانسان من ثمرة النخل والشجر والزرع التي يمر به. على ما تقدم في آخر الكلام في بيع الثمار والزرع والخضر من كتاب البيع.
(مسألة ٦٤): يحرم أكل الانسان من طعام لم يدع إليه، وفي الحديث: «من أكل طعاماً لم يدع إليه فإنما أكل قطعة من النار»، كما أن من دعي إلى طعام حرم عليه أن يأخذ ولده معه. نعم يحل الامران مع العلم برضا صاحب الطعام أوقيامه بما يكون قرينة عرفاً على رضاه بذلك.
(مسألة ٦٥): يحرم الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، كما يحرم الاكل منه. نعم يختص ذلك بحال شرب الخمر ولا يعم ما قبل ذلك وإن تهيأ صاحبها لأن يسقي الخمر عليه، كما لا يعم الطعام المجعول عليها بعد شرب الخمر. هذا كله مع قطع النظر عن النهي عن المنكر، أما إذا لزم من الجلوس عليها التشجيع على المنكر أو كان في القيام منها نهياً عنه حرم الجلوس مطلق، بل قد يحرم حينئذٍ الدخول للدار أو مواصلة صاحبه، أو غير ذلك حسب اختلاف المقامات.
الفصل الثامن
في آداب المائدة
واللازم - قبل النظر فيها - الاهتمام بطيب المكسب وحل الطعام وتجنب الحرام، ففي الحديث أن من أدخله بطنه النار فبعداً له. مضافاً إلى ما في ذلك من سوء الاثر في النفس وفي السلوك. بل عن الامام الصادق (عليه السلام) أنه قال: «كسب الحرام يبين في الذرية».
إذا عرفت هذ، فلندخل فيما عقد له هذا الفصل.
(مسألة ٦٦): يستحب الاقتصاد في الاكل ويكره الاسراف والافراط فيه، والامتلاء من الطعام. قال الله تعالى: (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحبّ المسرفين). وفي الحديث عن الامام الصادق (عليه السلام) قال: «أقرب ما يكون العبد من الله إذا خفَّ بطنه، وأبغض ما يكون العبد من الله إذا امتلا بطنه»، وعنه (عليه السلام) قال: «ليس بدّ لابن آدم من أكلة يقيم بها صلبه، فإذا أكل أحدكم طعاماً فليجعل ثلث بطنه للطعام وثلث بطنه للشراب وثلث بطنه للنفس، ولا تسمنوا تسمّن الخنازير للذبح»، وفي وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) لولده الحسن (عليه السلام): «لا تجلس على الطعام إلا وأنت جائع ولا تقم عن الطعام إلا وأنت تشتهيه وجوِّد المضغ...».
(مسألة ٦٧): يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده، والاستلقاء بعده ووضع الرجل اليمنى على اليسرى حين الاستلقاء.
(مسألة ٦٨): يستحب التسمية قبل الطعام والتحميد بعده، بل يستحب التحميد قبله أيضاً وفي أثنائه. ومن نسي التسمية في أول الطعام أتى بها متى ذكر يقول: «بسم الله على أوله وآخره».
(مسألة ٦٩): يستحب الاكل والشرب باليمنى ويكره باليسرى، إلا في العنب والرمان فيؤكلان باليدين مع.
(مسألة ٧٠): يستحب البدء بالملح والختم به، أو البدء بالخل والختم به، أو البدء بالملح والختم بالخل. والاول أفضل.
(مسألة ٧١): يستحب استقصاء الطعام عند الاكل تكريماً له وعدم ترك شيء منه وإن قلّ، وذلك باُمور..
الأول: مص الاصابع، ففي الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «فمن
مص أصابعه التي أكل بها قال الله عزوجل: بارك الله فيك»، وعن الامام الصادق (عليه السلام): «إني لالحس أصابعي من المأدوم حتى أخاف أن يرى خادمي أن ذلك من الجشع».
الثاني: لطع الاناء، فعن الامام الصادق (عليه السلام) أنه قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يلطع القصعة ويقول: من لطع القصعة فكأنما تصدق بثمنه».
الثالث: استقصاء الفاكهة من قشره، وعدم رمي القشر وفيه شيء منه.
الرابع: تتبع ما يسقط من الطعام في المنزل مهما كان قليل، فقد أكدت الاخبار على ذلك، وأنه شفاء من كل داء، وأنه ينفي الفقر عمن أكله ومن ولده وولد ولده إلى السابع، وأنه يكثر الولد، وأنه مهور الحور العين. وعن الامام الصادق (عليه السلام) أنه كان يتتبع من الطعام الذي يسقط من الخوان مثل السمسمة فيأكله، وعنه (عليه السلام) أنه قال: «إني لاجد الشيء اليسير يقع من الخوان فاُعيده فيضحك الخادم».
بل اللازم احترام الطعام وتكريمه كأدب عام لا يختص بالمائدة، فعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «من وجد تمرة أو كسرة ملقاة فأكلها لم تستقر في جوفه حتى يغفر الله له». وفي بعض الاخبار أنه تجب له بذلك الجنة. وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم): «من وجد كسرة فأكلها كان له حسنة، ومن وجدها في قذر فغسلها ثم رفعها كان له سبعون حسنة». وعن الامام الصادق (عليه السلام) أنه قال: «دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على عائشة فرآى كسرة كاد أن يطأها فأخذها وأكله، وقال: يا حميراء أكرمي جوار نعم الله عليك، فإنها لم تنفر عن قوم فكادت تعود إليهم».
ومما يؤسف له تسامح الناس في ذلك كثير، خصوصاً أهل النعم منهم، بطراً وأشراً وكفراً بنعمة الله تعالى واستهواناً به، وأمناً من مكر الله تعالى ومن تغييره ما بهم من نعمة. فما أكثر ما اُلقي منها في الطرق والمزابل، وما أكثر م
استهين بها بصورة تقشعر لها الابدان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ونعوذ به من حلول سخطه وتحويل عافيته وسلب نعمته.
(مسألة ٧٢): يستحب تخليل الاسنان بعد الطعام بالعيدان لآخراج ما تبقى فيه، وقد ورد التأكيد عليه في الاخبار وأنه مصلحة للثة ومجلبة للرزق، وأن تركه يوجب تغير رائحة الفم فيتأذى بذلك المَلَك. ويجوز التخلل بكل عود. لكن يكره بعود الريحان والرمان والقصب والخوص والآس والطرفاء.
(مسألة ٧٣): يستحب أكل بقايا الطعام في الفم مما يناله اللسان، وإلقاء ما أخرجه الخلال منه ويكره أكله.
وهناك آداب ومستحبات كثيرة للمائدة وللطعام لا يسع المقام استقصاءه، فلتطلب من المطولات.
ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق، وله الحمد.
كتاب الميراث
وهو ما حصله الانسان بجده أو جَمَعه بكده وأتعب فيه بدنه وأجهد فيه نفسه، وربما يكون قد أغمض في مطالبه لا يهمه أن حصله من حلال أو حرام، سالكاً في ذلك طرق الشبهات والآثام، أو يكون قد بخل به على نفسه، فلم ينتفع به في دنياه ولا في آخرته، ثم يتركه لمن بعده - بعد أن تحمل تبعته - يأكلونه ويتنعمون به، فيكون المهنأ لغيره والوزر على ظهره.
فعلى العاقل الرشيد الاهتمام بأمرين..
الأول: طيب المكسب وحل المال الذي يتركه، وأداء حق الله تعالى فيه، والخروج عن تبعاته، واكتساب ما يتيسر له من الحسنات به، ولا يبخل على نفسه بماله، فإنه ليس له من ماله إلا ما قدم.
الثاني: أن يكون ورثته أهلاً للاحسان لحاجتهم وتدينهم وحسن تصرفهم فلا يضيع المال فيهم، بل يؤجر على تركه لهم وتعففهم به عما عند الناس، واستغنائهم بسببه عنهم. ونسأله تعالى التسديد والتوفيق وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة.
ويقع الكلام في كتاب الميراث في ضمن فصول..
الفصل الاول
في موجبات الإرث
وهي قسمان..
الأول: النسب، وله ثلاث مراتب، لا ترث المتأخرة شيئاً مع ميراث السابقة وإن بقي منها واحد، إلا أن تنعدم السابقة أو تكون ممنوعة من الميراث لاحد موانع الارث الآتية.
الاُولى:الاب والاُم - دون الاجداد والجدات - والاولاد وإن نزلوا ذكوراً وإناث.
الثانية: الاجداد والجدات وإن علوا - كآباء الاجداد وأجدادهم - والاخوة والاخوات، ويلحق بهم أولادهم وإن نزلو، كأولاد أولادهم، وأولاد أولاد أولادهم.
الثالثة: الاعمام والاخوال وإن علو، كأعمام الاباء والاُمهات وأخوالهم، وأعمام الاجداد والجدات وأخوالهم، ويلحق بهم أولادهم وإن نزلو.
القسمالثاني: السبب. وهو الزوجية والولاء. وللولاء مراتب ثلاث: لا ترث المتأخرة شيئاً مع السابقة:
الاُولى: ولاء العتق.
الثانية: ولاء ضمان الجريرة.
الثالثة: ولاء الامامة. وجميعها متأخرة عن مراتب النسب. أما الزوجية فهي سبب للميراث مع جميع المراتب.
الفصل الثاني
في موانع الإرث
وهي ثلاثة..
الأول: الكفر، فلا يرث الكافر المسلم، ويرث المسلم الكافر. من دون فرق في الكافر بين أقسامه ولا في المسلم بين المؤمن والمخالف.
(مسألة ١): لا يحجب الكافر المسلم، بل يحجب المسلم الكافر وإن كان الميت كافر، سواءً كان الوارث المسلم مساوياً للوارث الكافر في الطبقة أم أبعد منه، فإذا مات مسلم أو كافر وله ولد كافر وولد مسلم كان الميراث للمسلم دون الكافر، وكذا إذا كان له ولد كافر وأخ أو ابن أخ مسلم، فإن الميراث يكون للمسلم دون الكافر.
(مسألة ٢): يستثنى مما تقدم ما إذا كان الميت كافراً وله أولاد صغار وورثة مسلمون أبعد منه طبقة، فإن على المسلمين أن ينفقوا من تركته على أولاده الصغار حتى يكبروا فإن أسلموا كان لهم ميراث أبيهم، وإن لم يسلموا أخذ ورثته المسلمون بقية ميراثه. وإن أسلم أولاده وهم صغار دفعت التركة للحاكم الشرعي وأنفق عليهم منها حتى يكبرو، فإن بقوا على الاسلام دفع إليهم ميراث أبيهم، وإن لم يبقوا عليه دفع ما تبقى من تركته لورثته المسلمين.
(مسألة ٣): إذا انحصر الوارث المسلم للكافر بالامام لم يحجب ورثته الكفار. ويستثنى من ذلك ما إذا ارتد المسلم عن فطرة وكان له ورثة كفار وانحصر وارثه المسلم بالامام، فإن ميراثه بسبب الارتداد لما اكتسبه قبل ارتداده يكون للامام لا لورثته الكفار، أما ميراثه بالموت لما اكتسبه بعد ارتداده فإنه
يكون لورثته الكفار، دون الامام. وكذا المرتد الملي فإن ميراثه بالموت لما ملكه حال إسلامه وبعد ارتداده يكون لورثته الكفار دون الامام. وقد تقدم جملة من أحكام الارتداد في مبحث ما يحرم بالكفر من كتاب النكاح.
(مسألة ٤): مع تعدد الوارث المسلم إذا أسلم الوارث الكافر قبل قسمة الميراث ورث، فإن كان هو أقرب ممن سبقه من المسلمين حاز الميراث كله دونهم، وإن كان في طبقتهم شاركهم في الميراث. وأما مع اتحاد الوارث المسلم فإن الميراث له، وإسلام الوارث الكافر لا يوجب ميراثه. نعم إذا لم يكن للميت وارث وكان ميراثه للامام فإن الوارث الكافر إذا أسلم يحوز الميراث من الامام ما دامت التركة موجودة ولم ينفقها الامام، أما إذا أنفقها وخرجت عنه فلا شيء للذي أسلم.
(مسألة ٥): إذا انحصر الوارث بالزوج فحيث يكون الميراث كله - كما يأتي في ميراث الازواج - فهو بحكم الوارث الواحد الذي سبق أن إسلام الوارث الكافر لا يمنعه من الميراث ولا يستحق الكافر معه بإسلامه شيئ. أما إذا انحصر الوارث بالزوجة فحيث إنها لا تستحق إلا الربع والباقي للامام يجري حكم تعدد الوارث، فإن أسلم الوارث الكافر قبل قسمتها مع الامام ورث، وإن أسلم بعد قسمتها مع الامام لم يرث.
(مسألة ٦): يلحق بالقسمة سائر وجوه تصفية الميراث المشترك، كما إذا وهب بعض الورثة حصته المشاعة للباقين، أو صالح عليها بمال أو أوقفها أو غير ذلك.
(مسألة ٧): إذا أسلم الكافر بعد قسمة بعض التركة دون بعضها فالظاهر جريان حكم عدم القسمة، فيرث من الكل حتى ما قسم.
(مسألة ٨): إذا قسم بعض الورثة وأخذ حصته وبقي باقي التركة مشاع
بين الباقين فهو بحكم عدم القسمة، كما إذا ترك الميت ثلاثة إخوة فاتفقوا على تعيين حصة أحدهم وبقي اثنان شريكين في باقي التركة فإن الوارث الكافر يختص بالميراث أو يشارك فيه بالاضافة إلى تمام التركة حتى الحصة التي اختص بها أحد الاخوة.
(مسألة ٩): إذا تصرف الورثة بأجمعهم في عين التركة قبل القسمة تصرفاً مخرجاً عن الملك فإن كان بعوض جرى على العوض حكم التركة فإذا أسلم الوارث قبل قسمته ورث منه، وإذا أسلم بعد قسمته لم يرث. وإن كان التصرف من دون عوض - كالصدقة والهبة - فالظاهر نفوذ التصرف منهم وعدم ضمانهم للعوض لو أسلم الوارث الكافر. وكذاالحال في التصرف المتلف للعين كالاكل، فإنه لا ضمان معه. ويجري ذلك في تصرف بعضهم في حصته في المسألتين السابقتين، فإنه إن كان تصرفاً بعوض جرى على العوض حكم الميراث في حق من يسلم، وإن كان تصرفاً متلفاً أو مخرجاً عن الملك من غير عوض فلا ضمان على المتصرف، وإنما يجري حكم الميراث في حق من أسلم على الباقي من التركة لا غير.
(مسألة ١٠): إذا تصرف بعض الورثة في التركة تصرفاً متلفاً للعين أو ناقلاً لها من دون رضا البقية، فإن كان الباقي واحداً كان التصرف المذكور بمنزلة القسمة، وإن كان الباقي متعدداً لم تتم القسمة إلا أن يقسم الباقون حصصهم من التركة أو من عوضه.
(مسألة ١١): المراد من المسلم والكافر الوارث والموروث ما يعم المسلم والكافر تبعاً كالطفل والمجنون المتصل جنونه بصغره اللذين يكفي في الحكم بإسلامهما انعقاد نطفتهما من أب مسلم، كما يكفي إسلام أبيهما أو من يكفلهما في الحكم بإسلامهما تبع، كما تقدم في الثامن من المطهرات، من مباحث الطهارة
من الخبث.
الثاني من موانع الارث: القتل، فلا يرث القاتل من المقتول إذا كان قتله بلا حق وإن كان خط، أما إذا كان بحق فهو يرثه، كما لو كان قصاصاً أو دفاعاً أو لهدر دمه بمثل سبه لله تعالى أو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو غير ذلك.
(مسألة ١٢): لا فرق في القتل بين القتل بالمباشرة، كما لو رماه بطلقة فمات، والتسبيب، كما لو كتفه وألقاه للاسد فافترسه.
(مسألة ١٣): لو أمر غيره بقتل رجل فامتثل أمره وقتله فعل حرام، إلا أنه لا يكون قاتل، ولا يمنع ذلك من ميراثه من المقتول.
(مسألة ١٤): إذا اشترك جماعة في قتل واحد حرموا كلهم من إرثه.
(مسألة ١٥): القاتل كما لا يرث من المقتول لا يحجب غيره عن ميراثه ممن هو أبعد منه وإن كان متقرباً به، فإذا قتل الاب ولده فإن كانت له اُم وأولاد كان ميراثه لهم، وإلا كان ميراثه للجد والاخوان، ثم لمن بعدهم من طبقات الورثة. وإذا قتل الولد أباه ولم يكن له أولاد غيره كان ميراثه لولد الولد مع وجوده، ثم لمن بعدهم من طبقات الورثة، ولو لم يكن له وارث غير القاتل إلا الامام كان الميراث للامام.
الثالث من موانع الارث: الرق، فلا يرث العبد وإن انحصر به الميراث. وحيث كان الابتلاء بذلك نادراً أو منعدماً في زماننا فلا نطيل بذكر فروعه.
الفصل الثالث
في ميراث المرتبة الاُولى
وهم الاب والاُم والابناء كما تقدم.
(مسألة ١٦): للاب المنفرد تمام المال وكذا للاُم المنفردة. ولو كان مع أحدهما زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع والباقي لاحد الابوين.
(مسألة ١٧): للولد المنفرد تمام المال، وكذا للبنت المنفردة. ولو كان مع أحدهما زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن والباقي للابن أو البنت. ولا ينتقل شيء من الميراث للمراتب اللاحقة، لما سبق في الفصل الاول من أن المرتبة اللاحقة لا ترث مع إرث السابقة وإن بقي منها واحد.
(مسألة ١٨): إذا انفرد الابوان بالميراث كان للاب الثلثان وللاُم الثلث، إلا أن يكون للميت إخوة، فيحجبون الاُم عما زاد عن السدس، ويكون الباقي للاب، وذلك بشروط..
الأول: أن يكونوا للاب أو للابوين، فلا يحجب الاخوة للاُم وحده.
الثاني: أن يكونوا أخوين فما زاد، أو ما هو بمنزلتهم، وهو الاخ والاُختان، أو أربع أخوات، فلا يحجب الاخ الواحد أو مع اُخت واحدة، ولا ثلاث أخوات فما دون.
الثالث: أن يكونوا أحياء منفصلين بالولادة، لا حمل.
الرابع: أن لا يكونوا مماليك ولا كفرة، وفي اشتراط أن لا يكونوا قاتلين للميت إشكال. والاظهر عدم الاشتراط، بل يحجب القاتل. فإذا تمت هذه
الشروط حجب الاخوة الاُم عما زاد عن السدس هنا وفي جميع صور وجود الاب. أما مع فقد الاب فلا يحجبونه.
(مسألة ١٩): إذا كان الوارث الابوان مع زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، وللاُم الثلث أو السدس - على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة - والباقي للاب
(مسألة ٢٠): إذا تعدد الابناء الذكور واختص الميراث بهم كان المال بينهم بالسوية، وكذا إذا تعددت البنات واختص الميراث بهن. وإذا كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن، وكان الباقي بين الابناء أو البنات بالسوية.
(مسألة ٢١): إذا اجتمع الابناء الذكور والاناث وانحصر الميراث بهم كان المال بينهم للذكر مثل حظ الاُنثيين. وإذا كان معهم زوج أو زوجة، كان للزوج الربع وللزوجة الثمن، والباقي بين الابناء والبنات للذكر مثل حظ الاُنثيين.
(مسألة ٢٢): إذا ترك الميت أحد الابوين مع ابن واحد أو أبناء متعددين كان لاحد الابوين السدس، والباقي للابن أو الابناء يقسم بينهم بالسوية. ولوكان هناك أيضاً زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن ولاحد الابوين السدس والباقي للابن أو الابناء يقسم بينهم بالسوية.
(مسألة ٢٣): إذا ترك الميت أبوين مع ابن واحد أو أبناء متعددين كان لكل واحد من الابوين السدس، والباقي للابن أو الابناء يقسم بينهم بالسوية. ولو كان هناك أيضاً زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن، ولكل واحد من الابوين السدس، والباقي للابن أو الابناء يقسم بينهم بالسوية.
(مسألة ٢٤): إذا ترك الميت أحد الابوين مع بنت واحدة كان لاحد الابوين الربع وللبنت الباقي. ولو كان معهما زوج أو زوجة كان للزوج الربع، وللزوجة الثمن، والباقي بين أحد الابوين والبنت، لاحد الابوين ربعه وللبنت ثلاثة أرباعه.
(مسألة ٢٥): إذا ترك الميت أبوين مع بنت واحدة كان لكل واحد من الابوين خمس، وللبنت ثلاثة أخماس. ولو كان معهم زوج كان له الربع، ولكل واحد من الابوين السدس، والباقي للبنت. أما لو كان معهم زوجة فإنه يكون لها الثمن، والباقي يقسم أخماس، لكل واحد من الابوين خمسه، وللبنت ثلاثة أخماسه.
(مسألة ٢٦): إذا ترك الميت أحد الابوين مع بنتين أو أكثر كان لاحد الابوين الخمس، والباقي للبنات تقسم بينهن بالسوية. فإن كان معهم زوج كان له الربع، ولاحد الابوين السدس، والباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية، أما لو كان معهم زوجة فلها الثمن، والباقي بين أحد الابوين والبنات، لاحد الابوين خمسه وللبنات أربعة أخماسه، تقسم بينهن بالسوية أيض.
(مسألة ٢٧): إذا ترك الميت أبوين مع بنتين أو أكثر كان لكل واحد من الابوين السدس، والباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية. فإن كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن ولكل واحد من الابوين السدس والباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية أيض.
(مسألة ٢٨): إذا ترك الميت أحد الابوين أو كليهما مع ابن واحد أو أكثر أو بنت واحدة أو أكثر كان لكل واحد من الابوين السدس، والباقي للابناء للذكر مثل حظ الاُنثيين. فإن كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن ولكل واحد من الابوين السدس والباقي للابناء للذكر مثل حظ الاُنثيين أيض.
(مسألة ٢٩): أولاد الاولاد يقومون مقام الاولاد عند عدمهم، ويحجبون المرتبة الثانية - وهي الاجداد والاخوان - ويأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به، فأولاد الابن يأخذون نصيب أبيهم، وأولاد البنت يأخذون نصيب اُمهم، وذلك بأن يفرض من يتقربون به موجود، فما يستحقه من الميراث يستحقه المتقربون به، فإذا كان للميت أولاد كثيرون قد توفوا في حياته ولم
يعقب عقباً باقياً إلا بعضهم فرض ذلك البعض موجوداً وحده حين وفاته فما يستحقه من الميراث يستحقه عقبه، دون غيرهم من ورثته، كالزوج والزوجة.
(مسألة ٣٠): لا يتوقف ميراث أولاد الاولاد على فقد الابوين، بل يرثون معهما ويحجبونهما عما زاد على السدس، كما أنهم يحجبون الزوجين عن نصيبهما الاعلى وهو النصف والربع، وينزلونهما إلى النصيب الادنى وهو الربع والثمن.
(مسألة ٣١): إنما يرث أولاد الاولاد إذا لم يكن للميت ولد للصلب، وإلا حجبهم وكان الميراث له دونهم وإن كان واحداً واُنثى، لانه أقرب منهم للميت من حيثية البنوة.
(مسألة ٣٢): أولاد أولاد الاولاد مهما نزلوا يقومون مقام آبائهم، طبقة بعد طبقة، فترث الطبقة اللاحقة عند فقد الطبقة السابقة، ولا ترث مع وجودهاوإن كان الموجود واحداً واُنثى ، لانها أقرب منها للميت.
(مسألة ٣٣): يقتسم أولاد كل ولد مع تعددهم نصيب أبيهم أو اُمهم بينهم، فإن اتحدوا جنساً كان بينهم بالسوية، وإن اختلفوا كان بينهم للذكر مثل حظ الاُنثيين.
(مسألة ٣٤): يختص الولد الذكر الاكبر بالحبوة، وهي مصحف أبيه الميت وخاتمه وسيفه وثيابه. ويستحب لبقية الورثة أن يعطوه بقية أقسام السلاح الذي للميت وكتب العلم التي اتخذها للانتفاع والراحلة - وهي البعير الذي كان الميت يتخذه لسفره - والرحل، وهو ما يجعل على ظهر البعير حين الركوب، بل الأحوط استحباباً العموم لكل ما يختص الميت به من الاثاث، خصوصاً ما يختص به في سفره.
(مسألة ٣٥): لايشترط في استحقاق الولد الاكبر للحبوة أن يكون بالغاً ولا رشيد، فيستحقها الصبي، بل الحمل، والسفيه، بل المجنون.
(مسألة ٣٦): لا يشترط في استحقاق الحبوة أن يترك الميت غيرها مما يكون
لبقية الورثة، فلو انحصرت التركة بها كانت للولد الاكبر ولم يستحق غيره شيئ.
(مسألة ٣٧): لا يبتني استحقاقه للحبوة على تعويضه للورثة ما يقابلها من التركة، بل يستحقها بتمامها من أصل التركة، زائداً على حصته من غيره. نعم هي متأخرة عن الدين المستوعب للتركة، فإذا أرادها كان عليه أن يؤدي ما يقابلها من الدين. ولو كان الدين مستوعباً لبقية التركة ولبعض الحبوة كان مقدماً عليها وكان على المحبو أن يفي ما يقابل ذلك البعض من الدين، فإذا كان مجموع التركة ثلاثين، وما يقابل الحبوة منها عشرة، وكان الدين خمسة وعشرين لحق الحبوة خمسة من الدين، فإذا وفاها استقل بالحبوة. أما إذا كان الدين ينقص عن مقدار الحبوة من التركة فلا يلحق الحبوة منه شيء ووجب وفاؤه من غيره. نعم إذا امتنع الورثة من الوفاء لم يستقل بالحبوة إلا بعد وفائه. فإن وفاه فالظاهر عدم جواز رجوعه على الورثة، وإن أرجع للحاكم الشرعي كان له ترخيصه في الوفاء بنية الرجوع عليهم فله الرجوع حينئذٍ، ويجري هذا في واجبات التجهيز التي تخرج من أصل التركة، فإنها تخرج مما عدا الحبوة مع وفائه به، ولا تخرج من الحبوة إلا مع عدم وفاء ما عدا الحبوة به.
(مسألة ٣٨): في جواز الوصية بأعيان الحبوة لغير الولد الاكبر إشكال، فاللازم الاحتياط بعدم الوصية بها لغيره، أو بإمضاء الولد الاكبر للوصية المذكورة، أو بالتصالح بين الولد الاكبر والموصى له به. ويجري ذلك في الوصية بثلث جميع التركة بنحو يشمله، فيجري الاحتياط المذكور بالاضافة إلى ثلث الحبوة.
(مسألة ٣٩): إذا كانت أعيان الحبوة مرهونة على دين في ذمة الميت وجب على الورثة وفاء الدين من غير الحبوة مع سعته لوفائه كسائر الديون. لكن ذلك لا يوجب حقاً للمحبو عليهم بحيث له إلزامهم به أو يكون له الوفاء عنهم والرجوع عليهم. أما إذا كان الدين في ذمة غير الميت فيقوم المحبو مقام الميت
حسب اتفاقه مع المدين الذي سلطه على رهن الاعيان المذكورة.
(مسألة ٤٠): الظاهر دخول القلنسوة والجورب والنعل في الحبوة، لتبعيتها للثياب. وكذا غمد السيف لتبعيته للسيف.
(مسألة ٤١): المراد بالثياب هي التي كان الميت يلبسها معداً لها للبس، دون ما أعده للّبس ولم يلبسه أو لبسه صدفة من دون إعداد للّبس، أو لبسه ثم أعرض عنه وتركه، فضلاً عما اتخذه للادخار أو التجارة، وكذا الحال في الخاتم.
(مسألة ٤٢): المراد بالمصحف هو المصحف الذي كان الميت يقرأ فيه معداً له لذلك،على نحوما تقدم في الثياب. والمراد بالسيف هو الذي اتخذه لنفسه ليقاتل به.
(مسألة ٤٣): إذا تعدد المصحف أو الخاتم أو السيف كان الجميع حبوة.
(مسألة ٤٤): المراد بالولد الاكبر هو الاسبق ولادة لا علوق.
(مسألة ٤٥): إذا تعدد الولد الاكبر للميت بأن ولد له أكثر من واحد في وقت واحد. فالظاهر اشتراكهم في الحبوة.
(مسألة ٤٦): تختص الحبوة بولد الصلب، ولا يستحقها الاكبر من أولاد الاولاد، ولا من أولاد الولد الاكبر.
(مسألة ٤٧): قيل: يستحب لكل من الابوين الوارثين لولدهما إطعام الجد والجدة المتقرب به سدس الاصل إذا زاد نصيبه عن السدس.
الفصل الرابع
في ميراث المرتبة الثانية
وهي الاخوة والاجداد. وقد سبق أنها لا ترث مع المرتبة السابقة، وإنما ترث مع فقده.
(مسألة ٤٨): إذا ترك الميت أخاً واحداً أو اُخت، أو جداً أو جدة، كان له المال كله. سواء كان الاخ والاُخت للاب والاُم، أم للاب وحده، أم للاُم وحده، وسواءً كان الجد أو الجدة للاب أم للاُم. فإن كان معه زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، والباقي للاخ أو الاُخت أو الجد أو الجدة.
(مسألة ٤٩): إذا ترك الميت إخوة فقط فالمال كله لهم، فإن كانوا كلهم للابوين قسّم المال مع اتحاد الجنس بينهم بالسوية، ومع اختلافه للذكر مثل حظ الاُنثيين. وكذا إن كانوا كلهم للاب فقط. أما إذا كانوا للاُم فقط فالمال يقسم بينهم بالسوية حتى مع اختلافهم في الجنس. فإن كان مع الاخوة زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، والباقي يكون للاخوة على النحو المتقدم.
(مسألة ٥٠): لا يرث الاخوة والاخوات للاب فقط مع الاخوة والاخوات للابوين، وإنما يرثون مع فقدهم. أما الاخوة للاُم فقط فإنهم يرثون مع الاخوة للابوين ومع الاخوة للاب فقط.
(مسألة ٥١): إذا ترك الميت إخوة بعضهم من الابوين أو الاب فقط وبعضهم من الاُم، فإن كان الذي من الاُم واحداً - ذكراً أو اُنثى - كان له السدس، وإن كان متعدداً كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية. والباقي للذي
من الابوين أو الاب فقط، فإن كان واحداً انفرد به، وإن كان متعدداً متحد الجنس قسّم بينهم بالسوية، وإن كان متعدداً مختلف الجنس قسّم بينهم للذكر مثل حظ الاُنثيين. فإن كان مع الاخوة في مفروض هذه المسألة زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، وللاخوة من الاُم نصيبهم المتقدم - وهو السدس مع الاتحاد والثلث مع التعدد - والباقي للاخوة من الابوين أو الاب.
(مسألة ٥٢): حيث سبق أن الاجداد في مرتبة الاخوة فلا يفرق في ذلك بين الجد القريب والجد البعيد، كأب الجد وجده واُم الجد أو الجدة وجدهم. نعم يحجب الجدُّ القريب الجد البعيد، فلا يرث البعيد مع وجود من هو أقرب منه، سواء كان الاقرب سبباً لاتصال الابعد بالميت، كأب الاب مع جد الاب، أم لم يكن كأب الاُم مع جد الاب.
(مسألة ٥٣): إذا ترك الميت جداً وجدة للاب وانحصر ميراثه بهما كان المال بينهما للجد الثلثان وللجدة الثلث، فإن كان معهما زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، والباقي بين الجدين للجد ثلثاه وللجدة ثلثه.
(مسألة ٥٤): إذا ترك الميت جداً وجدة للاُم وانحصر ميراثه بهما كان المال بينهما بالسوية. وإذا كان معهما زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع والباقي للجدين بالسوية.
(مسألة ٥٥): قد يترك الميت أجداداً بعضهم للاُم وبعضهم للاب أو الابوين، وذلك لا يكون في الجد إلا إذا كان بعيداً كجد الاب والاُم. وحينئذٍ إذا انحصر الميراث بهم كان للذي من قبل الاُم الثلث فإن كان واحداً انفرد به، وإن كان متعدداً اقتسموه بالسوية. والباقي للذي هو من قبل الاب أو الابوين، فإن كان واحداً انفرد به، وإن كان متعدداً فإن اتحدوا في الجنس كان بينهم بالسوية وإن اختلفوا اقتسموه بالتفاضل للذكر مثل حظ الاُنثيين. فإن كان معهم زوج
أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع. ولمن هو من قبل الاُم من الاجداد الثلث على النحو المتقدم. والباقي لمن هو من قبل الاب من الاجداد على النحو المتقدم أيض.
(مسألة ٥٦): إذا اجتمع الجد أو الجدة - واحداً أو متعدداً - مع الاخ أو الاُخت - واحداً أو متعدداً - فالمشهور أن الجد كواحد من الاخوة، فإن كان الجد للاُم قاسم الاخوة من الاُم نصيبهم المتقدم بالتساوي، وإن كان الجد للاب قاسم الاخوة من الاب نصيبهم المتقدم بالتساوي مع اتحاد الجنس، وبالتفاضل - للذكر مثل حظ الاُنثيين - مع اختلاف الجنس، كالجدة مع الاخوة، والجد مع الاخوات. وإن اجتمع الجد أو الجدة للاب مع الاخوة للاُم وحدهم كان كما لو اجتمع الاخ أو الاُخت للاب مع الاخوة للاُم، وإن اجتمع الجد أو الجدة للاُم مع الاخوة للاب وحدهم كان كما لو اجتمع الاخ للاُم مع الاخوة للاب.
ولكن الذي يظهر من النصوص أن الجد مطلقاً - للاب كان أو للاُم - مع الاخوة كواحد من الاخوة للاب، والجدة كواحدة من الاخوات للاب. ولا يكونان كواحد من الاخوة للاُم. وعليه إن انحصر الميراث بالجد - حتى لو كان للاُم - والاخوة للاب كان كواحد منهم يقسم الميراث بينهم للذكر مثل حظ الاُنثيين، وإن كان معهم أخ أو إخوة للاُم كان للاخ أو الاخوة للاُم نصيبهم المتقدم - من السدس أو الثلث - والباقي للجد والاخوة من الاب، وإن كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، والباقي للجد والاخوة من الاب. وإن انحصر الميراث بالجد - حتى لو كان للاُم - والاخ أو الاخوة للاُم كان للاخ أو الاخوة للاُم نصيبهم المتقدم، والباقي للجد، وإن كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، وللاخ أو الاخوة للاُم نصيبهم المتقدم والباقي للجد.
ويتعين العمل على ذلك، وإن كان الاحتياط بالصلح حسناً جد.
(مسألة ٥٧): يقوم أولاد الاخوة مقام الاخوة عند فقد الاخوة بأجمعهم فيشاركون الجد مع وجوده، ويستقلون بالميراث مع فقده. ويحجبون المرتبة الثالثة، وهي الاعمام والاخوال. أما مع وجود بعض الاخوة فلا يرث أولاد الاخوة وإن كانوا ولداً لغير الموجود. من دون فرق بين أقسام الاخوة من كونهم للابوين أو لاحدهم. فإذا وجد الاخ أو الاُخت للاب فقط أو للاُم فقط لم يرث أولاد الاخوة للابوين مع فقد آبائهم.
وهكذا الحال في أولاد أولاد الاخوة مهما نزلوا فإنهم يرثون - ويشاركون الجد - مع فقد من هو أعلى منهم طبقة ولا يرثون مع وجود بعض من هو أقرب منهم طبقة.
(مسألة ٥٨): يرث أولاد الاخوة والاخوات نصيب من يتقربون به بأن يفرض آباؤهم ورثة للميت، فما يرثه كل منهم يرثه ولده، فإذا كان للميت مثلاً خمسة إخوة قد أعقب منهم عقباً باقياً اثنان اُخت لابيه وأخ لاُمه، يفرض الاخوان المذكوران هما الوارثان للميت، وحيث كان ميراث الاخ للاُم السدس وللاُخت من الاب الباقي، يكون ميراث عقب الاخ للاُم السدس وإن كثرو، والباقي لعقب الاُخت للاب وإن كان واحداً ذكراً أو اُنثى.
(مسألة ٥٩): إذا كان عقب الاخ أو الاُخت واحداً انفرد بحصة من يتقرب به. وإن كان متعدداً اقتسموه بالسوية إن كان من يتقربون به أخاً أو اُختاً للميت من طرف اُمه فقط. وكذا إذا كان من يتقربون به أخاً أو اُختاً للميت من طرف أبيه، إذا كان العقب متحدين في الجنس، وإذا كانوا مختلفين في الجنس فالمشهور أنهم يقتسمونه بالتفاضل للذكر مثل حظ الاُنثيين، ولا يخلو من إشكال، فالأحوط وجوباً التصالح بينهم.
الفصل الخامس
في ميراث المرتبة الثالثة
وهي الاعمام والاخوال، وقد تقدم أنها لا ترث مع وجود المرتبة الثانية.
(مسألة ٦٠): إذا ترك الميت عماً واحداً أو عمة واحدة أو خالاً واحداً أو خالة واحدة كان له الميراث كله. فإن كان معه زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، والباقي للعم أو العمة أو الخال أو الخالة.
(مسألة ٦١): إذا تعدد الاعمام وانحصر الميراث بهم في طبقتهم كان لهم المال كله، إلا أن يكون معهم زوج أو زوجة فيستثنى نصيبهما المتقدم، ويبقى الباقي للاعمام. وحينئذٍ إن اتحدوا في الجنس - بأن كانوا كلهم ذكوراً أو إناثاً - كان المال بينهم بالسوية، وإن اختلفوا في الجنس كان المال بينهم للذكر مثل حظ الاُنثيين، فإن ترك عماً وعمة مثلاً كان للعم الثلثان وللعمة الثلث. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الاعمام جميعاً إخوة لاب الميت من أبويه أو من أبيه فقط أو من اُمه فقط، وأن يكونوا مختلفين.
نعم لا يرث المتقرب بالاب فقط مع وجود المتقرب بالابوين وإنما يرث مع فقده فيقوم مقامه، أما المتقرب بالاُم فقط فإنه يرث مع كل منهم،نظير ما تقدم في الاخوة. ولا يفرق في ذلك بين صورة انحصار الميراث بالاعمام - كما هو المفروض في هذه المسألة - ومشاركة الاخوال لهم.
(مسألة ٦٢): إذا تعدد الاخوال وانحصر الميراث بهم في طبقتهم كان لهم المال كله، إلا أن يكون معهم زوج أو زوجة، فيستثنى نصبيهما المتقدم،
ويبقى الباقي للاخوال. وحينئذٍ يقتسمون المال بالسوية. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الاخوال جميعاً إخوة لاُم الميت من أبويها أو من أبيها فقط أو من اُمها فقط، وأن يكونوا مختلفين.
نعم لا يرث المتقرب بالاب فقط مع وجود المتقرب بالابوين، أما المتقرب بالاُم فإنه يرث مع كل منهم، نظير ما تقدم في الاعمام.
(مسألة ٦٣): إذا اجتمع العم أو الاعمام مع الخال أو الاخوال، كان للخال أو الاخوال الثلث، يقسم بينهم على النهج المتقدم، وللعم أو الاعمام الباقي يقسم بينهم على النهج المتقدم. إلا أن يكون معهم زوج أو زوجة، فيكون للزوج النصف وللزوجة الربع، وللاخوال الثلث، وللاعمام الباقي، فيقع النقص على الاعمام وحدهم.
(مسألة ٦٤): أولاد الاعمام والعمات والاخوال والخالات يقومون مقام الاعمام والعمات والاخوال والخالات عند فقدهم جميع، ولا يرثون مع وجود بعضهم، فلا يرث ولد العم مع وجود أبيه أو غيره من الاعمام. بل لا يرث ولد العم مع الخال. وكذا الحال في ولد الخال، فإنه لا يرث مع وجود أبيه أو غيره من الاخوال، ولا مع وجود العم.
(مسألة ٦٥): يستثنى مما تقدم ما إذا ترك الميت عمه أخا أبيه لابيه فقط وابن عمه أخي أبيه لابيه واُمه، فإن ابن العم يمنع العم حينئذٍ. ولو كان معهما خال أو خالة حجب ابن العم وكان الميراث للعم والخال أو الخالة. ولو تعدد العم أو ابن العم أو كان معهما زوج أو زوجة ففي حجب العم وميراث ابن العم إشكال، والأحوط وجوباً التصالح.
(مسألة ٦٦): يرث أولاد الاعمام والاخوال ميراث من يتقربون به على النحو المتقدم في ميراث أولاد الاخوة، ويقتسمونه بينهم لو تعددوا على النحو
المتقدم هناك. فراجع المسألتين الاخيرتين من الفصل السابق.
(مسألة ٦٧): الاعمام والاخوال طبقات مترتبة، فأعمام الميت وأخواله مقدمون على أعمام أبويه وأخوالهم، وأعمام الابوين وأخوالهما مقدمون على أعمام الاجداد وأخوالهم وهكذ، وكل طبقة لا ترث إلا مع فقد جميع أفراد الطبقة السابقة عليه. بل أولاد كل طبقة وإن نزلوا يقومون مقام آبائهم، ويقدمون على الطبقة اللاحقة. وكل صنف منهم يرث نصيب من يتقرب به. ويقتسمون النصيب بينهم مع تعددهم على النهج المتقدم في ميراث أولاد الاخوة المتقدم في المسألة الاخيرة من الفصل السابق.
(مسألة ٦٨): قد يجتمع لوارث جهتان، وذلك على صور..
الاُولى: أن يكونا من نوع واحد، كالجدودة في مثل الجد للاب وللاُم.
الثانية: أن يكونا من نوعين من طبقة واحدة، كالخؤولة والعمومة. ومثاله ما إذا كان زيد أخا عمرو لابيه، وهند اُخت عمرو لاُمه، فتزوج زيد هنداً فأولدها بكر، فإن عمر يكون عم بكر وخاله، ومثل ذلك ما إذا كان الشخص عم أبي الميت وخال اُمه أو بالعكس.
الثالثة: أن تكون إحدى الجهتين نسباً والاُخرى سبب، كالقرابة والزوجية، كما لو كان الزوجان ابني عم. وفي الصور الثلاث يتعين الميراث من كلتا الجهتين، إلا أن تكون إحداهما مانعة من الاُخرى، فيرث بالجهة المانعة دون الممنوعة، كما في أخ هو ابن عم، كما لو تزوج زيد هنداً فأولدها عمر، ثم تزوجها أخوه فأولدها بكر، فإن بكراً أخو عمرو لاُمه وابن عمه.
الفصل السادس
في الميراث بالولاء
وقد تقدم أن الولاء متأخر عن مراتب النسب الثلاث، فلا يكون سبباً للميراث مع وجود أحده. كما تقدم أنه ثلاث مراتب أيض، ولا ترث المتأخرة شيئاً مع وجود المتقدمة.
الاُولى: ولاء العتق. فإن من أعتق عبداً كان له ميراثه بشروط أعرضنا عن ذكرها كما أعرضنا عن فروع ذلك، لندرة الابتلاء بالعتق في عصورنا أو عدمه.
الثانية: ولاء ضمان الجريرة. والمراد بالجريرة دية قتل الخطأ الذي تتحمله عاقلة القاتل، وهم ورثته على تفصيل يأتي في كتاب الديات إن شاء الله تعالى، فإذا لم يكن للانسان وارث نسبي، ولا معتق وارث فإن له أن يتولى شخصاً على أن يضمن جريرته، فإن فعل ذلك كان الضامن وارثاً له.
(مسألة ٦٩): لابد في حصول الولاء من ضمان الجريرة، فيترتب عليه الميراث، من دون حاجة للتنصيص عليه. نعم لا يضر التنصيص عليه مع ضمان الجريرة. ولا يكفي في الولاء الالتزام بالارث وحده من دون ذكر ضمان الجريرة، فإن اقتصر على الالتزام بالارث لم يترتب الميراث، فضلاً عن ضمان الجريرة.
(مسألة ٧٠): ضمان الجريرة من العقود. فهو عقد يتضمن الولاء من شخص لآخر على أن يضمن جريرته، ولابد فيه من الايجاب والقبول كسائر العقود، فيقول الضامن مثلاً: واليتك على أن أعقل عنك وأضمن جريرتك، فيقول المضمون: قبلت، أو يقول المضمون عنه: واليتك على أن تعقل عني وتضمن جريرتي، فيقول الضامن: قبلت.
(مسألة ٧١): يمكن فسخ عقد ضمان الجريرة بالتقايل من الطرفين. بل في لزومه في حق كل منهما بحيث ليس له فسخه من دون رضا الطرف الآخر إشكال، واللازم الاحتياط.
(مسألة ٧٢): يشترط في المضمون عنه أن لا يكون له من يعقل عنه من الارحام أو المعتق. وفي اشتراط عدم الوارث له وإن لم يكن عليه عقل كالنساء إشكال، وكذا الاشكال في بطلان عقد ضمان الجريرة لو حصل العاقل او الوارث من الارحام وتجدد بعد العقد.
(مسألة ٧٣): ضمان الجريرة إنما يقتضي ميراث الضامن للمضمون، ولا يقتضي ميراث المضمون للضامن، إلا أن يكون الضمان من الطرفين.
(مسألة ٧٤): إذا مات ضامن الجريرة لم ينتقل الضمان لورثته.
(مسألة ٧٥): ضامن الجريرة يرث جميع المال، إلا أن يكون معه زوج أو زوجة، فيكون للزوج النصف وللزوجة الربع، ولضامن الجريرة الباقي.
الثالثة: ولاء الامامة. فإن الامام وارث من لا وارث له من المراتب السابقة للنسب والولاء.
(مسألة ٧٦): إذا لم يكن للميت وارث إلا الزوجة كان لها الربع، والباقي للامام. أما إذا انحصر الميراث بالزوج فإنه له النصف بالاصل، ويرد عليه النصف الثاني أيض، ولا يرثه الامام.
(مسألة ٧٧): إذا أوصى من لا واث له بماله كله في المسلمين والمساكين وابن السبيل نفذت وصيته ولم يكن للامام شيء. أما إذا أوصى بجميع ماله في غير ذلك فلا تنفذ وصيته إلا في الثلث، وكان الباقي للامام.
(مسألة ٧٨): إذا كان الامام ظاهراً كان الميراث له يعمل به ما يشاء.
وقد روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان يفرقه في فقراء أهل بلد الميت. وأما في عصر الغيبة فيجري عليه حكم سهم الامام عليه السلام من الخمس يراجع فيه الحاكم الشرعي وعليه أن يتولى صرفه في مصارف السهم المذكور. والاولى صرفه في المحتاجين من أهل بلد الميت.
(مسألة ٧٩): المراد بمن لا وارث له من يعلم بعدم الوارث له من الارحام المسلمين والمعتق وضامن الجريرة، كالذي يسلم من الكفار وحده ويموت قبل أن يحصل له وارث مسلم من الطبقات السابقة أو ينفرد بنسبه حتى يبعد من يشاركه في النسب بحيث لايصدق عليه أنه رحمه. ويلحق به اللقيط قبل أن يعرف أهله، دون من كان له وارث من المسلمين إلا أنه لا يعرف بسبب انقطاعه عن أهله وبعده عنهم كالمسافر المنقطع والحاضر المنحاز عن أهله لخوف أو نحوه، بحيث لا يعرف أهله، فإن مثل هذا لا يرثه الامام، بل يرثه أهله وإن كانوا مجهولين، فيجري على تركته حكم مجهول المالك من وجوب الفحص عن صاحبه. ومع اليأس عن العثور عليه يجوز أن يتصدق به على الفقراء عن صاحبه، على ما تقدم في ذيل كتاب اللقطة.
الفصل السابع
في ميراث الازواج
الزوجية من أسباب التوارث بين الزوجين إذا كانت دائمة، أما إذا كانت منقطعة فلا توجب التوارث إلا مع اشتراطه في عقد الزواج، وفي صحة اشتراط الميراث لاحدهما دون الآخر إشكال.
(مسألة ٨٠): لا يشترط في توارث الزوجين الدخول، فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر، إلا في زواج المريض فإنه لا يصح من دون دخول، فلا
يترتب عليه الميراث، كما تقدم في أواخر فصل العيوب والشروط من كتاب النكاح.
(مسألة ٨١): يلحق بالزوجية العدة الرجعية، فإنها بحكم الزوجية يثبت التوارث مع موت أحد الزوجين فيه. كما تقدم في أواخر الفصل االرابع من كتاب الطلاق. كما يلحق بها المطلقة من قبل المريض إلى سنة بشروط تقدمت في آخر الفصل الثالث من كتاب الطلاق أيض.
(مسألة ٨٢): مما تقدم يظهر أن للزوج النصف من زوجته إذا لم يكن لها ولد ذكر ولا اُنثى، وإن نزل كولد الولد، والربع إذا كان لها ولد. وللزوجة الربع من زوجها إذا لم يكن له ولد، والثمن إذا كان له ولد. ولا ينقصان عن ذلك ولا يزادان مع جميع طبقات الميراث. إلا الزوج مع عدم وجود وارث للزوجة غير الامام، فإنه له تمام المال، وليس للامام شيء، كما تقدم في الفصل السابق.
(مسألة ٨٣): مع تعدد الزوجات وما اُلحق بهن يشتركن في سهم الزوجية المتقدم بالتساوي.
(مسألة ٨٤): الزوج كسائر الورثة يرث نصيبه من جميع ما تتركه الزوجة من الارض وغيرها من المنقول وغيره. أما الزوجة فإنما ترث نصيبها من المنقول - كالنقود والبضائع والسفن والحيوانات وغيرها - دون الارض المجردة أو العامرة بالبناء أو الزرع أو نحوهم، فإنها لا ترث من عينها ولا من قيمته. نعم ترث مما ثبت فيها من البناء والشجر والاخشاب والالات ونحوه. وللوارث دفع قيمة ذلك ويجب عليها القبول به.
(مسألة ٨٥): الثابت في الارض إن كان تابعاً لها أو للبناء عرفاً لم تستحق الزوجة من عينه بل من قيمته كعريش العنب والناعور وتجهيز الماء والكهرباء والابواب والمغاسل ونحوه. وإن لم يكن تابعاً لها وإنما ثبت فيها لتوقف أداء وظيفته على ذلك، فالظاهر أنها تستحق سهمها من عينه كالمعامل المنصوبة في
الارض والمكائن الزراعية ونحوه، فليس للوارث إلزامها بقبول القيمة.
(مسألة ٨٦): كيفية التقويم في البناء أن تُقوّم أجزاؤه بذاتها لا بما أنها مبنية. وفي مثل النخل والشجر أن يقوّم بما هو نخل أو شجر أو نحوها غير مستحق للبقاء في الارض.
(مسألة ٨٧): ترث الزوجة من عين ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج، وليس للوارث إجبارها على القيمة.
(مسألة ٨٨): إذا لم يدفع الوارث القيمة فإن كان عن تراض منه ومنها واتفاق بينهما فهما على اتفاقهم. وإن لم يكن عن تراض منهما كان لها سهمها من اُجرة أجزاء البناء على من استوفى منفعته. ولها سهمها من عين ثمرة الشجر ونحوه.
(مسألة ٨٩): إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء قبل دفع القيمة للزوجة فالظاهر أن لها المطالبة بسهمها من العين وليس للوارث إجبارها على أخذ القيمة. بخلاف ما إذا كان البناء مستعداً للانهدام والشجر مستعداً للقلع أو القطع، فإنه ليس لها المطالبة بسهمها من العين، بل للوارث إجبارها على أخذ القيمة. نعم إذا خرج الشجر عن كونه شجراً بل صار حطباً فالظاهر أنه كالثمر تستحق سهمها من عينه وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته.
(مسألة ٩٠): القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاته، وللوارث إجبارها على أخذ القيمة. أما الماء الموجود فيها فإنها ترث من عينه، وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته.
(مسألة ٩١): إذا حفر سرداباً أو بئراً قبل أن يصل إلى حد النبع فإن كان فيه بناء استحقت منه، وكان للوارث إجبارها على أخذ القيمة، وإن لم يكن فيه بناء فلا تستحق منه شيئاً - كالارض - حتى لو كان له قيمة في نفسه أو كان سبباً في زيادة قيمة الارض التي حفر فيه. ومثل ذلك ما إذا شق في الارض طريقاً أو
أنشأ فيها سدة ترابية أو نحو ذلك.
(مسألة ٩٢): إذا لم يدفع الوارث القيمة للزوجة فإن كان ذلك عن رضا منه بمشاركتها في العين وإسقاط منه لحقه في التبديل بالقيمة نفذ ذلك عليها وعليه وليس له الرجوع فيه، وإن لم يكن كذلك، بل كان عن عجز منه عن القيمة أو تسويف منه في دفعها فلا يلزم بذلك، وله دفع القيمة متى شاء.
(مسألة ٩٣): المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع. إلا أن يتصالح الوارث والزوجة على قيمة معينة قبل الدفع، فتلزم عملاً بمقتضى الصلح.
(مسألة ٩٤): الزوجة وإن كانت لا ترث من الارض - كما سبق - إلا أنها ترث من الحقوق المتعلقة بالارض كحق السرقفلية وحق الخيار الذي لا يشترط فيه المباشرة وينتقل للوارث، فإذا باع الزوج الارض أو اشتراها بخيار إلى أجل ثم مات ورثت الزوجة الحق المذكور ولم يختص به غيرها من الورثة، بل هي مثلهم في السلطنة على إعمال الحق المذكور بالنحو الذي يأتي توضيحه في الخاتمة إن شاء الله تعالى.
(مسألة ٩٥): ما يخرج من أصل التركة كالديون والواجبات المالية يؤخذ من أرض وغيرها من أقسام التركة بالنسبة، فإذا كان مجموع التركة مثلاً مائة وعشرين ألف دينار ثلثها أرض وثلثاها غير أرض، وكانت الاُمور المذكورة من الديون وغيرها بقدر أربعين ألف دينار، فثلثها يخرج من الارض، وثلثاها من الباقي لعدم المرجح، وعليه يكون ثُمن الزوجة ثلثي العشرة آلاف دينار. ولا مجال لآخراجها بأجمعها من غير الارض المستلزم لكون ثمن الزوجة خمسة آلاف دينار، لأن في ذلك إجحافاً بالزوجة، ولا لآخراجها بأجمعها من الارض المستلزم لكون ثمن الزوجة عشرة آلاف دينار تامة، لأن في ذلك اجحافاً ببقية الورثة. وهذا أمر قد يغفل عنه.
الفصل الثامن
في ميراث ولد الملاعنة والزن
والحمل والمفقود
(مسألة ٩٦): تقدم في فصل اللعان من كتاب الطلاق أن ولد الملاعنة ترثه اُمه ومن يتقرب بها - كالاخوة للاُم والجد للاُم والاخوال - دون الاب ومن يتقرب به - كالاخوة للاب والجد للاب والاعمام - وعلى ذلك يكون إخوته لابويه بحكم إخوته لاُمه، فيشاركون إخوته لاُمه في ميراثهم، وتكون قسمة الميراث بين الجميع بالسوية.
(مسألة ٩٧): كما ترثه اُمه ومن يتقرب بها يرثه بقية الورثة غير الاب ومن يتقرب به كالزوجين وضامن الجريرة والامام. وعلى ذلك يفرض كما لو لم يكن له أب ولا من يتقرب به وتجري على تركته قسمة المواريث في حق غيرهم وفق الضوابط المتقدمة فيمن لم يكن له أب ولا من يتقرب به، فلا نطيل بإعادته.
(مسألة ٩٨): لا يرث ولد الملاعنة أباه، ولا قرابة أبيه كإخوته من أبيه وجده لابيه وأعمامه، ولا يرثه أبوه ولا أحد منهم.
(مسألة ٩٩): إذا ادعى الاب بعد الملاعنة الولد وأكذب نفسه اُلحق الولد بالاب وورث الاب دون قرابة الاب، فإنه لا يرثهم بذلك. أما الاب فلا يرث الولد إذا ادعاه.
(مسألة ١٠٠): يرث ولد الملاعنة اُمه وإخوته من اُمه وإخوته من أبيه واُمه، لكن يحكم عليه بأنه أخوهم من اُمهم لا غير.
(مسألة ١٠١): يرث ولد الملاعنة جده لاُمه مطلق، وكذا يرث أخواله إذا ادعاه أبوه بعد الملاعنة. وأما إذا لم يدعه أبوه ففي ميراثه من أخواله إشكال، فاللازم الاحتياط.
(مسألة ١٠٢): يرث ولد الملاعنة بقية الناس ويرثونه بأسباب الميراث الشرعية كالزوجية والولاء.
(مسألة ١٠٣): إذا تبرَّأ الاب من جريرة ابنه ومن ميراثه فلا أثر للتبرؤ من الميراث، فإن مات الولد ورثه أقرب الناس إليه سواءً كان الاب أم غيره.
(مسألة ١٠٤): ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني ولا من يتقرب به ولا يرثهم هو، ولا ترثه اُمه الزانية ولا من يتقرب بها ولا يرثهم هو، بل يثبت التوارث بينه وبين غيرهم من الورثة كأولاده والزوج أو الزوجة، كما يورث ويرث بالولاء كولاء ضمان الجريرة والامامة على النحو المتقدم في غيره. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل أحكام الاولاد من كتاب النكاح.
(مسألة ١٠٥): إذا كان الزنا من أحد الابوين مع الشبهة من الآخر ثبت التوارث بينه وبين صاحب الشبهة ومن يتقرب به دون الزاني ومن يتقرب به، كما تقدم هناك أيض.
(مسألة ١٠٦): الحمل حين موت المورث يرث منه إذا سقط حياً بأن صاح أو تحرك حركة الحياة أو غير ذلك مما يعلم منه حياته. أما إذا سقط ميتاً فإنه لا يرث وإن كان حياً قبل انفصاله عن اُمه وتمام ولادته.
(مسألة ١٠٧): تثبت حياة المولود بالبينة وهي رجلان عدلان. كما تثبت بشهادة أربع نساء. ولو شهدت امرأة واحدة ثبت بشهادتها ربع الميراث، فإن كانتا اثنتين ثبت نصف الميراث، فإن كنّ ثلاثاً ثبت ثلاثة أرباع الميراث. نعم لو حصل العلم بقولها أو قولهن ثبت له تمام الميراث في حق من حصل له العلم.
(مسألة ١٠٨): إذا سقط حياً فورث سهمه ثم مات ورثه أقرب الناس إليه.
(مسألة ١٠٩): إذا علم باتحاد الحمل عزل له عند قسمة الميراث سهم واحد، وإن علم بتعدده عزل له بقدره، ولو شك في ذلك اقتصر على الاقل. إلا أن يرضى الورثة بعزل الأكثر احتياط. كما أنه إن علم بكونه ذكراً عزل له سهم الذكر، وإن علم بأنه اُنثى عزل له سهم الاُنثى، وإن جهل حاله عزل له سهم الذكر احتياطاً حتى يتبين الحال. فإن تبين حاله عمل عليه. وإن مات ولم يتبين حاله تعين الصلح بين وارثه وبقية الورثة.
(مسألة ١١٠): المفقود لغيبة ونحوها إذا لم يعلم حياته ولا موته يتربص بماله أربع سنين مع الفحص عنه في الارض، وعشر سنين من دون فحص ولو لتعذر الفحص، ثم يحكم بموته، فيدفع ماله لوارثه بعد مدة التربص. كما أنه إذا مات له مورث قبل مضي مدة التربص حكم بإرثه منه. أما إذا مات بعد مدة التربص فلا يحكم بإرثه منه. وقد تقدم في أواخر كتاب الدين ما ينفع في المقام، لأن المقامين من باب واحد.
هذا إذا لم يكن له من يكلف بالانفاق عليه، أما مع وجوده - كما لو كان له أولاد محتاجين - فيجوز الانفاق عليه من ماله قبل مدة التربص.
(مسألة ١١١): إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه توارث، على تفصيل تقدم في فصل أحكام الاولاد من كتاب النكاح.
الفصل التاسع
في ميراث الخنثى وما يشبهه
المعيار في الذكورة والاُنوثة في الانسان شرعاً على العضو الذكري والعضو الاُنثوي، فواجد العضو الذكري وحده ذكر، تترتب عليه أحكام الذكر شرع، وواجد العضو الاُنثوي وحده اُنثى تترتب عليه أحكام الاُنثى شرع، ولا عبرة بغير ذلك من لوازم الذكورة والاُنوثة الغالبية ظاهرة كانت - كاللحية في الذكر وكبر الثديين في الاُنثى - أو خفية كالاحساسات الغريزية التي يدركها الشخص نفسه وكالهرمونات الذكرية والاُنثوية التي يعرفها أهل الاختصاص في زماننا هذ، لامكان الشذوذ الخلقي في اللوازم المذكورة.
ويترتب على ذلك أمران..
الأول: أنه لا يتحول الذكر اُنثى ولا الاُنثى ذكراً بعملية جراحية أو أدوية تستهدف الفوارق الجسدية بين الجنسين. نعم لو تبدل الحال خلقياً بمعجزة أو نحوها تحقق التحول عرف، إلا أن ذلك لو وقع فهو شذوذ في التكوين لا يخضع لسيطرة الانسان.
الثاني: أن الخنثى هو الانسان الواجد للعضوين مع، ولا عبرة بغيرهما من الخواص مهما كانت. وحينئذٍ إن علم بأنه من أحد الجنسين، لعدم كون العضو الآخر حقيقي، وإنما هو بصورة العضو عمل على العلم المذكور. وإلا فلا طريق للعلم بأنه من أحد الجنسين، مع قطع النظر عن الامارات الاتية، لانه بعد كون معيار الجنس هو العضو دون بقية الخواص، وفرض وجود العضوين مع،
كيف يتيسر العلم بأنه من أحد الجنسين !. ومن ثم لابد من النظر في العلامات الشرعية. وهو ما عقد له هذا الفصل..
(مسألة ١١٢): الخنثى إن كان يبول من فرج الرجال دون فرج النساء اُلحق بالرجال واستحق ميراثهم، وإن كان يبول من فرج النساء دون فرج الرجال اُلحق بالنساء واستحق ميراثهن.
(مسألة ١١٣): الخنثى إن كان يبول من الفرجين معاً كان العمل على ما يسبق منه البول. فإن كانا سواءً في ذلك فالعمل على ما ينبعث منه البول ويقوى اندفاعه.
(مسألة ١١٤): إذا لم يعلم حال الخنثى من جهة البول، فإن تيسر عدّ أضلاعه من الجانبين، فإن اختلفت بأن كانت سبعة عشر تسعة في اليمين وثمانية في اليسار فهو رجل، وإن تساوت بأن كانت ثمانية عشر في كل جانب تسعة فهو اُنثى.
(مسألة ١١٥): إذا لم يتيسر الرجوع للامارات السابقة في تعيين حال الخنثى إما لتعارضها أو لعدم وضوحه، كما لو مات قبل أن يبول أولم يتضح عدد أضلاعه، صار الخنثى مشكلاً الذي يأتي حكمه.
(مسألة ١١٦): يعطى الخنثى المشكل نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الاُنثى. وذلك بأن يفرض ذكراً ويقسم الميراث بينه وبين بقية الورثة على الفرض المذكور، ثم يفرض اُنثى ويقسم الميراث بينه وبين بقية الورثة على الفرض المذكور. ثم يعطى هو وبقية الورثة نصف كل من السهمين الحاصل في الفرضين. مثلاً إذا ترك الميت ولداً ذكراً وخنثى، يقسم الميراث اثني عشر سهم، فإذا فرض الخنثى ذكراً كان له ستة وللذكر ستة، وإذا فرض الخنثى اُنثى كان له أربعة وللذكر ثمانية، فيعطى الخنثى نصف كل من السهمين، وهو خمسة ويعطى الذكر نصف كل من السهمين، وهو سبعة. وإذا ترك الميت ذكرين وخنثى يقسم الميراث ثلاثين سهماً فإذا فرض الخنثى ذكراً كان له عشرة، ولكل من الذكرين
عشرة، وإذا فرض الخنثى اُنثى كان له ستة، ولكل من الذكرين اثنى عشر، فيعطى الخنثى نصف كل من السهمين، وهو ثمانية، ويعطى كل من الذكرين نصف كل من السهمين وهو أحد عشر. وإذا ترك الميت أباً وولداً خنثى يقسم الميراث أربعة وعشرين سهم، فإذا فرض الخنثى ذكراً كان له عشرون وللاب أربعة، وإذا فرض الخنثى اُنثى كان له ثمانية عشر وللاب ستة، فيعطى الخنثى نصف كل من السهمين وهو تسعة عشر، ويعطى الاب نصف كل من السهمين وهو خمسة. وعلى هذا تجري قسمة الميراث في جميع فروض المسألة.
(مسألة ١١٧): من ليس له عضو الذكر ولا عضو الاُنثى يورث بالقرعة يكتب على سهم (عبد الله) وعلى سهم (أمة الله) ثم يدعو المقرع الله ويبتهل إليه في كشف الحال، ثم يطرح السهمان في سهام ليس عليها كتابة ثم تشوش السهام ثم يأخذ المقرع سهماً فسهماً حتى يقع على أحد السهمين المكتوب عليهما فأيهما خرج أولاً عمل عليه، وورث المولود على مقتضاه.
(مسألة ١١٨): الأحوط وجوباً أن يكون الاقتراع برضا الورثة كلهم عند إرادة معرفة الحال من أجل قسمة المال، ولا يكتفى بتسرع شخص بالاقتراع من دون مراجعتهم. بل الأحوط وجوباً أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي.
(مسألة ١١٩): يستحب أن يقول المقرع عند الدعاء: (اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بيّن لنا أمر هذا المولود حتى كيف يورث ما فرضت له في الكتاب).
(مسألة ١٢٠): إذا لم يعلم حال المولود أنه ذكر أو اُنثى لموانع خارجية، كما لو غرق أو أكله السبع أو نحو ذلك، ففي الرجوع للقرعة - كما في الفاقد للعضوين - أو للتنصيف - كما في الخنثى المشكل - وجهان فلا يترك الاحتياط بالتصالح.
(مسألة ١٢١): من له رأسان على صدر واحد أو بدنان على حقو واحد
يترك حتى ينام ثم ينبه، فإن انتبها جميعاً كان له ميراث واحد، وإن انتبه أحدهما دون الآخر كان له ميراث اثنين. والظاهر التعدي من الميراث إلى سائر أحكام الواحد والمتعدد.
الفصل العاشر
في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
الغرقى والمهدوم عليهم إن علم بالمتقدم منهم موتاً والمتأخر ورث المتأخر من المتقدم ولم يرث المتقدم من المتأخر، وإن علم بتقارنهم في الموت لم يرث بعضهم من بعض، وإن جهل المتقدم والمتأخر ورث بعضهم بعض.
(مسألة ١٢٢): كيفية التوراث بينهم أن يفرض كل طرف حياً حين موت الآخر، فيرث من مال الآخر الاصلي الذي كان له في حياته، ثم يعكس الفرض، فيفرض الآخر حياً حين موت صاحبه، فيرث من ماله الذي كان له في حياته دون المال الذي ورثه من الاول. مثلاً: إذا غرق الزوجان وكان للزوج أربعمائة دينار وللزوجة أربعة آلاف درهم، ولم يكن لهما أولاد، فرض الزوج حياً حين موت زوجته فيرث منها ألفا درهم، ثم فرضت الزوجة حية حين موت زوجها فترث منه مائة دينار، فيدفع لورثة الزوج الآخرين ثلاثمائة دينار بقية تركته الاصلية وألفا دينار التي ورثها من زوجته، ويدفع لورثة الزوجة ألفا درهم بقية تركتها الاصلية ومائة دينار التي ورثتها من زوجه.
ويجري هذا لو كان الغرقى أو المهدوم عليهم الذين يرث بعضهم من بعض أكثر من اثنين، كأب واُم وولدهم. فيفرض الاُم والولد حيين حين موت الاب فيرثان من ماله الاصلي، ويفرض الاب والولد حيين حين موت الاُم فيرثان من مالها الاصلي، ويفرض الاب والاُم حيين حين موت الولد فيرثان
من ماله الاصلي، ثم يدفع لوارث كل منهم غير الغريق بقية مال مورثه الاصلي وما ورثه من الغريقين الآخرين.
(مسألة ١٢٣): كما يفرض كل طرف حياً حين موت الآخر من أجل ميراثه منه، كذلك يفرض حياً من أجل ميراث الحي غير الغريق من المال الاصلي للغريق لو كان لحياته أثر في ذلك. مثلاً: إذا غرقت الزوجة مع ابنتها من غير الزوج ولم يكن لها ذرية غيرها وبقي الزوج، فالزوج يرث من المال الاصلي للزوجة الربع لا النصف، للحكم ببقاء بنتها حين موته، والثلاثة الارباع الباقية من مال الزوجة للبنت الغريقة مع اُمها تدفع لورثة البنت. كما أنه لو كان للبنت في الفرض مال أصلي فلا يكون بتمامه لابيه، بل له منه الثلثان، للحكم بحياة اُمها حين موتها فترث من المال المذكور الثلث، ويكون لورثة الاُم، ومنهم الزوج.
(مسألة ١٢٤): كما يفرض كل طرف حياً من أجل ميراثه من الآخر ومن أجل ميراث الحي منه - كما تقدم - كذلك يفرض حياً من أجل منع ميراث غريق آخر منه لو كان حاجباً له. مثلاً: لو غرق أب وولداه، فلا توارث بين الولدين الاخوين، للحكم بحياة الاب عند موت كل منهما فيكون حاجباً للآخر، لأن الاب يحجب الاخ، فيحكم في الفرض مع تأخر الورثة الاحياء لكل منهم عن صاحبيه طبقة بانتقال المال الاصلي لكل من الولدين للاب، وبانتقال المال الاصلي للاب لهما مع. مثلاً: إذا كان للاب غنم، وللولد الكبير ألف دينار وللصغير ألف درهم حكم بميراث الاب من الولدين الدراهم والدنانير، وبميراثهما من أبيهما الغنم بالتناصف. والظاهر عدم ميراث كل منهما من الاب ما ورثه الاب من الآخر. فلا يرث الكبير من أبيه الدراهم التي ورثها من الصغير، ولا يرث الصغير من أبيه الدنانير التي ورثها من الكبير، بل يقتصر ميراثهما على الغنم يدفع لورثة كل منهما حصته منه ويختص الوارث الحي للاب بالدراهم والدنانير.
(مسألة ١٢٥): لا يشترط في ميراث بعضهم من بعض التوارث من الجانبين، بل لو كان أحد الطرفين يرث من الآخر دون العكس ثبت الميراث كذلك، فلو غرق أخوان لاحدهما أولاد دون الآخر ورث صاحب الاولاد أخاه ولم يرثه أخوه، بل يكون ميراثه لاولاده، فيصير لهم ماله الذي كان عنده في حياته وما ورثه من أخيه الغريق معه.
(مسألة ١٢٦): لا يشترط في ميراث بعضهم من بعض أن يكون لكل من الطرفين مال، فلو كان لاحد الطرفين مال دون الآخر ورث من ليس له مال من صاحبه ولم يرث صاحبه منه، فيكون المال لوارث من ليس له مال، ولا يبقى لوارث من له مال شيء إذا كان الغريق حاجباً له. مثلاً: إذا غرق أخوان لاُم ولكل منهما عم ليس له وارث غيره بعد الاخ وكان لاحدهما مال دون الآخر فالمال يصير لعم من ليس له مال، ولا يبقى لعم من له مال شيء.
(مسألة ١٢٧): إذا مات المتوارثون بغير الغرق والهدم، فهنا صور..
الاوُلى: أن يعلم بالمتقدم والمتأخر، ولا إشكال في ميراث المتأخر من المتقدم دون العكس.
الثانية: أن يعلم بالتقارن، ولا إشكال - حينئذٍ - في عدم الثوارث، نظير ما تقدم في الغرقى والمهدوم عليهم.
الثالثة: أن يتردد الامر بين التقارن وعدمه. وحينئذٍ إن علم تاريخ موت بعضهم وجهل تاريخ موت الآخر حكم بميراث مجهول تاريخ الموت من معلوم تاريخ الموت دون العكس، فإذا مات الاب والابن وعلم بأن الاب مات عند الزوال ولم يعلم بتاريخ موت الابن حكم بميراث الابن من الاب وعدم ميراث الاب من الابن. وإن جهل تاريخ موت كل منهما حكم بعدم التوارث منه، فكل منهما لا يرث الآخر.
الرابعة: أن يعلم بعدم التقارن مع الجهل بالمتقدم والمتأخر، فإن علم بتاريخ موت أحدهم وجهل تاريخ موت الآخر حكم بميراث مجهول تاريخ الموت من معلوم تاريخ الموت، نظير ما سبق في الصورة الثالثة. وإن جهل تاريخ الموت في الكل فقيل بالرجوع للقرعة في تعيين الوارث. ولكن الظاهر عدم الرجوع إليه، بل يحكم بعدم التوارث. وإن كان الأحوط استحباباً الصلح ولو بالرجوع للقرعة.
هذا كله في فرض التوارث من الجانبين، أما إذا كان الميراث من جانب واحد - كما إذا مات أخوان لاحدهما أولاد دون الآخر - فمع العلم بالتقارن لا ميراث كما تقدم. ومع عدم العلم به أو العلم بعدمه فإن علم تاريخ موت المورث وجهل تاريخ موت الآخر حكم بالميراث. وإن جهل التاريخان فلا ميراث، وإن كان الأحوط استحباباً التصالح.
ثم أنه لا يفرق في هذه المسألة بتفاصيلها بين موتهم جميعاً حتف الانف، وموتهم جميعاً بسبب غير الغرق والهدم - كالقتل في الحرب وافتراس السباع - واختلافهم بأن مات بعضهم حتف أنفه وبعضهم بسبب غير الغرق والهدم، أو بسبب الغرق أو الهدم، بل وكذا لو مات بعضهم بالغرق وبعضهم بالهدم. فالمعيار في هذه المسألة على عدم موتهم جميعاً بالغرق وعدم موتهم جميعاً بالهدم.
خاتمة
فيها مسائل:
الاُولى: سهام المواريث المتقدمة إنما تجري فيما يقبل القسمة عرفاً ولو بنحو الاشاعة وهي الاموال عيناً كانت أو ديناً أو منفعة، وكذا الحقوق المقابلة بالمال، كحق السرقفلية الذي تقدم الكلام فيه في آخر كتاب الاجارة، فلو بيع قسـم الثمن بين الورثة قسمة سهام المواريث. أما الحقوق غير المقابلة بالمال - كحق القصاص والخيار - فهي لا تقبل القسمة، حتى بنحو الاشاعة، ولا تجري السهام فيه، بل يشترك فيها الورثة بنحو المجموعية، فالحق الواحد يكون ملكاً لجميع الورثة ويكون تحت سلطنة الكل بنحو المجموعية فليس لكل منهم إعماله أو إسقاطه إلا برضا الآخرين. أما لو صالحوا عنه بمال قابل للقسمة ففي جريان سهام المواريث فيه إشكال، بل الظاهر قسمته بين الكل بالتساوي، إلا مع قيام القرينة على ابتناء الصلح من الكل على قسمته قسمة المواريث، فيكون العمل على ذلك.
الثانية: سهام المواريث المتقدمة إنما تجري بعد خروج الديون والواجبات المالية وواجبات التجهيز والوصية، فالمراد بالثلث أو السدس مثلاً في المواريث هو الثلث أو السدس من الباقي بعد إخراج الاُمور المذكورة، لا من أصل التركة. ولعل هذا من الواضحات.
الثالثة: يلحق بمال الميت الذي يجري عليه الميراث وتنفذ منه الوصايا والديون دية قتله، سواءً كانت مستحقة ابتداء وهي دية الخطأ أم كانت بدلاً عن القصاص في القتل العمدي إذا رضي أولياء الميت. وأما دية الجروح والاعضاء فما كان منها بسبب العدوان عليه في حياته فهو قد ملكه قبل موته وصار من
أمواله الحقيقية التي تركه. وما كان منها بسبب العدوان عليه بعد وفاته ينفق في وجوه البر عنه، ولا يلحق بأمواله ولا يجري عليه الميراث. نعم يوفى منه ديونه لو انحصر وفاؤه به، لانه من أفضل وجوه البر.
الرابعة: يرث الدية كل من يرث المال عدا الاخوة للاُم فقط، فإنهم لا يرثون منه. وألحق بهم المشهور كل من يتقرب بالاُم فقط كالاخوال وأبنائهم، ولا يخلو عن إشكال. بل الاظهر عدم إلحاقهم بالاخوة، بل هم يرثون من الدية كغيرهم من الورثة.
الخامسة: قد تختلف قسمة المواريث عند المخالفين عن قسمتها عندن، وحينئذٍ إذا ثبت للمؤمن حق بمقتضى قسمتها عندهم لا يثبت بمقتضى قسمتها عندنا جاز له الاخذ به إلزاماً لهم بمقتضى دينهم. والملزم بذلك هو الوارث الذي يدخل عليه النقص ويأخذ المؤمن منه ما يستحقه في مذهبه، لا الميت، فلابد من كون الوارث المذكور مخالفاً ليلزم بمقتضى مذهبه، سواء كان الميت مؤمناً أم مخالف، ولا أثر لكون الميت مخالفاً في ذلك.
السادسة: لما كان الميراث يجري على ما يملكه الميت فلا تورث الاراضي الميتة التي قد سبق تسجيلها باسم الميت شراء من الدولة أو هبة منها لعدم ملكيته له، كما سبق في أول كتاب إحياء الموات. بل هي على إباحتها الاصلية يملكها كل من يحييها وليس للورثة منعه منه. نعم لا يجب عليهم التنازل للمحيي بالطابو ولهم أخذ مال في مقابل ذلك.
كما أن الارصدة التي في البنوك التابعة لجهات غير مالكة لا يجري عليها التوارث وما يؤخذ في مقابلها إما مباح أصلي أو مجهول المالك. نعم الأحوط وجوباً لمن يقبض المال أن يدفعه للورثة على نحو سهام المواريث وعدم خروجه في المال المذكور عن مقتضاه.
والحمد لله رب العالمين
كتاب القصاص والديات
قد شدد الله تعالى في كتابه المجيد وعلى لسان رسوله الامين والائمة من أهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين في دم المؤمن وانتهاك حرمته وأكد على ذلك، فقد قال تعالى: (من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميع)، وعن الامام زين العابدين (عليه السلام) أنه قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا يغرنكم رحب الذراعين بالدم، فإن له عند الله قاتلاً لا يموت، قالوا: يا رسول الله وما قاتل لا يموت؟ فقال: النار»، وفي عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لمالك الاشتر (رضوان الله عليه): «إياك والدماء وسفكها بغير حله، فإنه ليس شيء أدنى لنقمة ولا أعظم لتبعة ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقه، والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة»، وعن الامام الباقر (عليه السلام) أنه قال: «من قتل مؤمناً متعمداً أثبت الله على قاتله جميع الذنوب، وبرئ المقتول منه. وذلك قول الله عزوجل: (إني اُريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار)».. إلى غير ذلك.
بل ورد التشديد في الاعانة على قتل المؤمن والاشتراك فيه والرضا به، فعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «والذي بعثني بالحق لو أن أهل السماء والارض شركوا في دم امرئ مسلم ورضوا به لأكبهم الله على مناخرهم [وجوههم] في النار»،
وعن الامام الباقر (عليه السلام) أنه قال: «إن الرجل ليأتي يوم القيامة ومعه قدر محجمة من دم فيقول: والله ما قتلت ولا شركت في دم، فيقال: بلى ذكرت عبدي فلاناً فترقى في ذلك حتى قتل فأصابك من دمه»، وعن الامام الصادق (عليه السلام) أنه قال: «من أعان على مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله»... إلى غيرذلك.
وكذا يحرم إيواء القاتل ومنعه من أولياء المقتول، كما تظافرت بذلك الاخبار عن أهل بيت العصمة الاطهار صلوات الله عليهم أجمعين.
لكن الجرم مهما عظم فباب التوبة منه مفتوح، رحمة من الله تعالى بعباده واستصلاحاً لامرهم وإبعاداً لهم عن القنوط المهلك. نعم التوبة مشروطة..
أولاً: بتسليم المعتدي نفسه لاولياء المقتول، فإن شاؤوا اقتصو، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وإن شاؤوا عفو.
وثانياً: بأداء الكفارة إن رضي أولياء المقتول بالدية ولم يقتصو، وقد تقدم التعرض لها في كتاب الكفارات.
وقد جعل الله سبحانه القصاص حقاً لاولياء المقتول على القاتل وثقّل في الدية تعظيماً لحرمة القتل وردعاً عنه، قال عز اسمه: (ولكم في القصاص حياة يا اُولي الالباب).
كما أنه تعالى قد خص القصاص بالمعتدي ولم يرض به على غيره عدلاً منه تعالى في الحكم، قال عز اسمه: (ولا تزر وازرة وزر اُخرى)، وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «إن أعتى الناس على الله عزوجل من قتل غير قاتله ومن ضرب من لم يضربه» والاخبار في ذلك كثيرة.
لكن مع كل ذلك نرى كثيراً من الناس ينتهكون حرمات الله تعالى
ويتعدون حدوده - استخفافاً وتهاوناً وطغياناً وتجبراً - فهم يستخفون بالدماء ويتسرعون في إهراقها ثم هم يمنعون القاتل من أن يقتص منه ويدافعون عنه عصبية وحمية. كما أنهم يعصبون الدم بغير القاتل من الاهل والعشيرة ويقتصون منهم، رجوعاً لعادات الجاهلية الجَهْلاء، واندفاعاً وراء العصبية الحمقاء، واستجابة لدعوة الشيطان الرجيم، وعزوفاً عن دين الله القويم وصراطه المستقيم (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون)، و(إن الذين يحادُّون الله ورسوله اُولئك في الاذلين * كتب الله لاغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز)، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
وقد رأينا أن نقتصر في هذا الكتاب على المهم من أحكام القصاص والديات على ما هو مورد للابتلاء من ذلك سداً لحاجة المؤمنين، مع إيكال بقية الفروع والاحكام للمطولات، حيث يضيق المقام عن استقصاء الكلام فيه. ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
ويقع الكلام في ذلك في قسمين..
القسم الأول
في القصاص
وهو جزاء الجناية على البدن بمثله، والكلام فيه في ضمن فصول..
الفصل الأول
في قصاص النفس
من قتل نفساً كان لاولياء المقتول الاقتصاص منه وقتله بشروط..
الأول: أن يكون كامل، بأن يكون عاقلاً بالغ، فلا قصاص على المجنون وإن كان عامداً وكذا الصبي، وإن بلغ خمسة أشبار على الأحوط وجوب.
(مسألة ١): في ثبوت القصاص على السكران إذا بلغ حداً لا يعتد بقصده عن العقلاء إشكال. نعم لو كان يعلم من نفسه أنه إذا سكر اعتدى فأقدم على السكر كان عليه القصاص. كما أنه إذا لم يكن سكره أثر في جنايته فلا إشكال في عدم القصاص عليه. كما إذا رمى بما لايقتل عادةً فقتل اتفاقاً أو رمى حيواناً فأصاب إنسان، كما يتحقق ذلك من السكران كثير.
الثاني: أن يكون القتل عمد، فإن لم يكن عمداً لم يكن عليه قصاص. بل تثبت بقتله الدية على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.
(مسألة ٢): القتل على أنحاء ثلاثة..
الأول: العمد، ويتحقق بالقصد للقتل وإن كان بفعل ما لا يوجبه عادة، كما إذا رمى رجلاً بحصاة صغيرة أو ضربه بعصا صغيرة ضربة خفيفة أو دفعه دفعاً خفيفاً فصادف قتله بذلك. كما يتحقق بالقصد إلى إصابة المقتول بما يتوقع به القتل عادة، بحيث لا يستغرب تحقق القتل به، وإن لم يقصد بذلك القتل.
الثاني: الشبيه بالعمد، ويتحقق بما إذا قصد إصابة المجني عليه بما لا يوجب القتل عادة من دون أن يقصد به القتل فصادف حصول القتل.
الثالث: الخطأ المحض، وهو الذي لا يقصد به إصابة المجني عليه، كما لو رمى شاة أو كافراً مهدور الدم فأصاب إنساناً مسلماً فقتله. وأولى من ذلك ما إذا لم يقصد به الفعل الذي تحقق به القتل، كما إذا مشى على سقف فخسفه فوقع على شخص فقتله، أو أخذ السلاح الناري ليصلحه فانطلقت منه رصاصة فأصابت شخصاً فقتلته ونحو ذلك.
الثالث: أن يكون المقتول حراً إن كان القاتل حر، فلا يقتص من الحر بقتل العبد ويقتص من العبد بقتل الحر أو العبد. ولا مجال لاطالة الكلام في ذلك وفي فروعه بعد عدم الابتلاء به أو ندرته.
الرابع: أن يكون المقتول مسلماً إن كان القاتل مسلم، فلا يقتص من المسلم بقتل الكافر، ويقتص من الكافر بقتل المسلم والكافر.
(مسألة ٣): إذا قتل الكافر المسلم دفع الكافر إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه وإن شاؤوا عفو. وكذا يدفع لهم ماله. وإن أسلم قبل الاسترقاق لم يسترق، وكان لهم القتل أو العفو.
(مسألة ٤): إذا قتل الكافر كافراً اقتص منه إلا أن يسلم القاتل قبل القصاص فلا يقتل حينئذٍ، بل ليس لاولياء المقتول إلا الدية إن كان للمقتول دية.
(مسألة ٥): إذا تعمد المسلم قتل الذمي اقتص منه بعد أن يعطى فضل
ما بين دية المسلم والذمي، فإن دية الذمي ثمانمائة درهم، على ما يأتي في محله إن شاء الله تعالى.
الخامس: أن لا يكون القاتل أباً للمقتول، فلا يقتص من الاب لو قتل ابنه، ويقتص من الابن لو قتل أباه، كما يقتص من الاُم لو قتلت ولده، ومن الولد لو قتل اُمه، لكن بعد رد فاضل الدية إن كان ذكر.
السادس: أن لا يكون المقتول مجنون، فإن من قتل مجنوناً لا يقتص منه.
(مسألة ٦): الأحوط وجوباً عدم الاقتصاص من الرجل إذا قتل الطفل غير البالغ.
السابع: أن يكون القاتل مبصر، فإن كان أعمى فلا قصاص، بل تثبت الدية وتحملها عاقلته، لانه في حكم قتل الخط.
الثامن: أن يكون القتل محرم، فلو كان سائغاً في حق القاتل فلا قصاص، كما في سابّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والائمة (عليهم السلام) ، والمرتد الفطري قبل توبته، والمقتول بقصاص أو حدّ، والمهاجم لو قُتل دفاع.
(مسألة ٧): الظاهر ثبوت القصاص بقتل من عليه القتل حداً - كاللائط والزاني المحصن - إذا تولاه من ليس له إقامة الحد. وكذا بقتل من عليه قصاص إذا تولاه من ليس له القصاص من دون توكيل منه.
(مسألة ٨): إذا قتل المولود الشرعي ولد الزنا المحكوم بإسلامه ثبت لوليه القصاص، ولكن يعطى للقاتل فاضل الدية، فإن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم كما يأتي.
(مسألة ٩): يثبت القصاص على الرجل بقتله للرجل وللمرأة، ويثبت القصاص على المرأة بقتلها للرجل وللمرأة. لكن لو قتل الرجل المرأة لم يقتل به
إلا بعد دفع فاضل الدية له، فإن دية المرأة نصف دية الرجل. أما لو قتلت المرأة الرجل فهي تقتل به لا غير، ولا يجب عليها دفع فاضل الدية لاوليائه.
(مسألة ١٠): إذا اجتمع اثنان على قتل واحد فأمسكه أحدهما وقتله الآخر كان القصاص على القاتل، وكان على من أمسكه أن يخلَّد في السجن حتى يموت عقوبة وحدّ، فإن كان معهم ثالث ينظر إليهم لا يغير عليهم وهو يقدر على التغيير كانت عقوبته أن تسمل عيناه.
(مسألة ١١): إذا أمر رجل رجلاً بقتل رجل آخر فقتله كان على القاتل القصاص، وعلى الامر أن يخلّد في السجن حداً وعقوبة. إلا أن يكون المأمور عبداً للامر، فيقتل الامر ويخلّد العبد في السجن. ويجري ذلك فيما لو كان الامر أو المأمور أو المقتول امرأة. أما لو كان المأمور صغيراً غير مميز أو مجنوناً كذلك فيقتل الامر مطلقاً ولا شيء على المأمور. وأما لو كان المأمور صبياً مميزاً فلا قصاص على الامر ولا على المأمور، بل يخلّد الامر في السجن، وتثبت الدية على المأمور تؤديها عنه عاقلته، كما يظهر مما يأتي في الديات.
(مسألة ١٢): إذا اشترك أكثر من واحد في قتل واحد ثبت القصاص عليهم. وحينئذٍ يتخير الولي في استيفائه بين وجوه..
الأول: أن يقتص منهم جميعاً بعد رد فاضل الدية على كل منهم، فإذا كانا اثنين رد عليها دية تامة بينهم، وإن كانوا ثلاثة رد عليهم ديتان بينهم، لكل منهم ثلثا دية، وإن كانوا أربعة رد عليهم ثلاث ديات بينهم لكل منهم ثلاثة أرباع الدية، وهكذ.
الثاني: أن يقتص من واحد منهم، وحينئذٍ يجب على من بقي أن يرد على ولي المقتص منه ما فضل من الدية، فإن كان من بقي واحداً دفع إليه نصف الدية، وإن كانا اثنين دفع كل واحد منهما ثلث الدية، وإن كانوا ثلاثة دفع إليه
كل منهم ربع الدية، وهكذ.
الثالث: أن يقتص من بعضهم أكثر من واحد. مثلاً إذا كان المشتركون في القتل أربعة كان له أن يقتص من اثنين، بعد أن يدفع لكل منهما نصف الدية، ويدفع الاثنان الباقيان كل منهما ربع الدية لوليي المقتص منهما فيكون لكل واحد من المقتولين المقتص منهما ثلاثة أرباع الدية، وهكذا بقية الصور المتصورة.
والضابط أن على كل مشترك من دم القتيل بنسبة شركته، فإن استوفى منه أكثر من ذلك بالاقتصاص منه كان له الفاضل من الدية على المستوفي للقصاص وعلى من لم يقتص منه ممن شارك في القتل بنسبة شركتهم. ومن ذلك يظهر أنه لو كان المشترك في القتل امرأة فقد لا يكون لها رد مع الاقتصاص منه، لأن ديتها نصف دية الرجل، فلو كان القاتل للرجل امرأتين كان لولي القتيل قتلهما معاً من دون رد عليهم. ولو كان القاتل رجلاً وامرأة كان له قتل الرجل وترد المرأة على ولي الرجل نصف الدية، وله قتل المرأة، ويرد الرجل نصف الدية على ولي القتيل لا على ولي المرأة، وعلى هذا النهج تجري بقية الصور المتصورة.
(مسألة ١٣): في كل مورد يجوز القصاص مع رد الولي فاضل الدية، يتعين تقديم رد الفاضل للجاني ثم الاقتصاص منه، ولا يحل الاقتصاص منه قبل الرد. أما لو كان الرد من غير الولي - كما تقدم في المسألة السابقة - فلا يتوقف الاقتصاص على تقديم الرد، بل يجوز الاقتصاص للولي قبله، ويجب بعده أن يرد بقية الجناة على ورثة المقتص منه.
(مسألة ١٤): إذا قتل الجاني أكثر من واحد كان لاولياء كل قتيل الاقتصاص منه. فإن اجتمعوا على الاقتصاص منه فلا شيء لهم. وإن عفا بعضهم أو رضي بالدية وقبل بها الجاني لم يسقط حق الباقين من القصاص. وإن سبق بعضهم بالقصاص من دون مراجعة الباقين فقد استوفى حقه. وهل
يسقط حق الباقين، أو ينتقلون للدية - كما فيمن تعذر الاقتصاص منه - وجهان أقواهما الثاني.
(مسألة ١٥): المسلمون تتكافأ دماؤهم، فكل مسلم محترم الدم يثبت القصاص بقتله مهما كان نسبه ومن أي فرقة كان، بعد مراعاة الشروط المتقدمة.
الفصل الثاني
في أحكام القصاص
(مسألة ١٦): لا يثبت القصاص إلا بعد موت المجني عليه، فمن اقتص قبله بعد الجناية كان ظالماً للجاني وكان لولي الجاني حينئذٍ القصاص من المقتص، أو الرضا بالدية أو العفو. نعم إذا مات المجني عليه الاول بعد قتل الجاني ثبتت ديته في مال الجاني المقتول.
(مسألة ١٧): لا يستحق ولي المقتول مع القتل العمدي إلا القصاص. وليس له الالزام بالدية بدلاً عن القصاص إلا برضا الجاني. وحينئذٍ فلهما التراضي بما زاد على الدية أو نقص عنه.
(مسألة ١٨): إذا توقف القصاص من ولي المقتول على رده فاضل الدية للجاني كان لولي المقتول الخيار بين القصاص مع الرد وأخذ الدية، وليس للجاني الامتناع من الدية.
(مسألة ١٩): إذا تعذر القصاص في قتل العمد للخوف من القاتل أو موته أو لمنع السلطان من القصاص أو نحو ذلك ثبتت الدية في ماله، فإن لم يكن له مال بقيت في ذمته كسائر ديونه. نعم إذا هرب القاتل فلم يقدر عليه ولم يكن له مال اُخذت الدية من قرابته الاقرب له فالاقرب، فإن لم يكن له قرابة كانت
الدية على الامام، ولا يتعدى لغير ذلك من صور تعدد القصاص.
(مسألة ٢٠): إذا صالح الجاني على الدية ثم امتنع من أدائها فلا يعود حق القصاص ويبقى مطالباً بالدية، وكذا إذا عجز عن أدائها فإنها تبقى في ذمته كسائر ديونه ولا يتحملها عاقلته عنه ولا الامام.
(مسألة ٢١): إذا أراد ولي المقتول القصاص من القاتل، فخلصه شخص أو قوم حتى امتنع الاقتصاص على الولي اُلزم الذي خلصه بإرجاعه وحبس حتى يحضره، فإن فدى نفسه بالدية ورضي بها ولي المقتول فذاك، وإن لم يفعل حتى مات القاتل اُلزم بالدية.
(مسألة ٢٢): يثبت حق القصاص لولي الميت وهو وارث المال وفي ثبوته للزوج والزوجة إشكال، نعم هما يرثان من الدية لو رضي بها الوارث بدلاً عن القصاص. وكذا من الدية الثابتة ابتداء، وهي دية الخط. وأما ما تعارف عند كثير من القبائل من إناطة الامر بغير الوارث، كرئيس القبيلة وأكابرها فهو من عادات الجاهلية التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. واللازم على المؤمنين نبذ ذلك والرضوخ لاحكام الله تعالى والمحافظة على حدوده لينالوا بذلك رضاه ويستحقوا رحمته، وإلا تعرضوا لنقمة الله تعالى وعقابه في الدنيا والآخرة.
(مسألة ٢٣): لولي الميت القصاص، وأخذ الدية برضا الجاني وبدونه على اختلاف الصور المتقدمة. كما أن له العفو، إلا الامام فإنه ليس له العفو، بل لابد له إما من القصاص أو أخذ الدية.
(مسألة ٢٤): إذا كان المقتول مسلماً وليس له أولياء من المسلمين إلا الامام وكان له أولياء من أهل الذمة عرض عليهم الامام الاسلام فمن أسلم منهم فهو وليه، فإن شاء اقتص وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية، وإن لم يسلم منهم أحد كان الامر للامام، وليس له إلا القصاص أوأخذ الدية، كما تقدم.
(مسألة ٢٥): إذا كان ولي المقتول مولى عليه لصغر أو جنون فالظاهر أن لوليه العمل على ما فيه صلاحه من القصاص أو الدية أو العفو. والأحوط وجوباً له الاقتصار على مقتضى المصلحة المهمة التي يكون تفويتها تفريطاً في حقه عرف. ومع عدم وضوحها للولي ينتظر به حتى يرتفع الحجر عنه فيعمل حقه بنفسه.
(مسألة ٢٦): إذا كان ولي الميت محجوراً عليه لسفه أو فلس لم يمنعه ذلك من طلب القصاص، كما لا يمنعه من الرضا بالدية.
(مسألة ٢٧): يجوز لولي الميت المبادرة بالقصاص وإن كان الاولى استئذان الامام، أو نائبه الخاص، وفي عصر الغيبة يستأذن الحاكم الشرعي.
(مسألة ٢٨): إذا تعدد الاولياء كان لكل منهم الاقتصاص من القاتل منفرد، لكن مع ملاحظة حق الآخرين، فإن رضوا بالقصاص فذاك، وإن أراد بعضهم الدية دفع له سهمه منه، وإن عفا بعضهم دفع سهمه من الدية لاولياء المقتص منه. وإن كان بعضهم غائباً لم يبطل حقه، بل ينتظر حتى يحضر فيعمل حقه، وكذا إذا كان مجنوناً أو صغيراً فإنه لا يبطل حقه بل يعمله وليه أو ينتظر به ارتفاع الحجر عنه، كما تقدم.
(مسألة ٢٩): للولي استيفاء القصاص بنفسه مباشرة، أو بتوكيل غيره على أن يقوم به مجاناً أو باُجرة، وتكون الاُجرة عليه لا على المقتص منه.
(مسألة ٣٠): إذا كان المقتول ناقصاً - كمقطوع اليد أو الرجل أو فاقد العين - ثبت القصاص أو الدية على قاتله وإن كان تاماً ولا يجب على أولياء المقتول رد دية العضو الناقص على القاتل. نعم إذا كان المقتول مقطوع اليد اليمنى قصاصاً أو كان قد جني عليه في قطعها فأخذ ديتها كان على أوليائه رد دية اليد قبل القصاص، وإذا أخذوا الدية استثنوا دية اليد. وفي عموم ذلك لليد
اليسرى فضلاً عن بقية الاعضاء إشكال، بل منع.
(مسألة ٣١): المقتول عمداً إن كان عليه دين وليس له مال فلاوليائه القصاص ولا يضمنون الدين. نعم إذا عفوا في قتل العمد والخطأ ضمنوا الدين. ولو أخذوا الدية كان عليهم وفاء الدين منه.
(مسألة ٣٢): اللازم في القصاص قتل الجاني بما يجهز عليه من دون تعذيب ومثلة ونحوهما حتى لو كان قد قتل المجني عليه بالوجه المذكور. والمشهور أنه لا يقتص منه إلا بالسيف، ولكن الظاهر الاكتفاء بكل ما يجهز عليه كالسلاح الناري. هذا كله مع استسلامه للقصاص جبراً أو اختيار، أما مع امتناعه بحيث لا يمكن الاقتصاص منه إلا مباغتة فالظاهر جواز ما تيسر من الوجوه مع تحري الابعد عن التعذيب والاقرب للاجهاز.
(مسألة ٣٣): إذا أراد ولي الدم أن يقتص من الجاني فضربه ضربة غير قاتلة كان ضامناً لما حصل منه، فإن كان عامداً وكانت الضربة مما يقتص فيه كان على ولي الدم القصاص، وإلا كان عليه دية الضربة له، ثم يقتص منه. نعم إذا ضربه ضربة قاتلة حتى ظن أنه أجهز عليه لكنه عولج فبرئ فالأحوط وجوباً سقوط القصاص بذلك.
(مسألة ٣٤): ليس للمجني عليه قبل موته حق العفو أواختيار القصاص أو الدية، ولو اختار شيئاً من ذلك فلا أثر له، بل يبقى الحق للولي.
الفصل الثالث
في قصاص الطرف
والمراد منه ما لا تبلغ فيه الجناية إزهاق النفس، سواءً اقتضت إتلاف عضو - كاليد والعين - أم ل، بل مجرد الاعتداء على البدن بمثل الجرح والخدش. فإنه يثبت في ذلك القصاص بالمثل في الجملة على تفصيل يتضح مما يأتي.
(مسألة ٣٥): يشترط في قصاص الطرف ما يشترط في قصاص النفس من كمال الجاني - بالبلوغ والعقل - وعمده، وحرية المجني عليه إذا كان الجاني حر، وإسلامه إذا كان الجاني مسلم، وعدم كون الجاني أباً للمجنى عليه وعدم كون المجني عليه، مجنوناً بل ولا صبياً على الأحوط وجوب، وأن يكون الجاني مبصر، وأن تكون الجناية محرمة، على التفصيل المتقدم هناك.
(مسألة ٣٦): الظاهر أن الجناية عمداً على الطرف موجبة لتخيير المجني عليه بين القصاص والدية، فإن اختار الدية فليس للجاني الامتناع، بخلاف الجناية على النفس، كما تقدم.
(مسألة ٣٧): إذا جنت المرأة على الرجل كان له القصاص بالمثل لا غير، وإذا جنى الرجل على المرأة كان لها القصاص منه بلا رد ما لم تبلغ دية الجناية ثلث دية قتل الرجل، فإذا بلغت ثلث الدية نزلت ديتها إلى النصف وكان عليها رد فاضل الدية. فمثلاً: إذا قطع الرجل إصبعاً أو إصبعين أو ثلاثاً من أصابع المرأة كان لها القصاص من دون رد، فإن قطع أربعاً كان لها القصاص مع رد نصف دية الاصابع المذكورة. وإذا فقأ الرجل عين المرأة أو قطع رجلها كان لها القصاص بفقء عينه أو قطع رجله مع رد نصف دية العين والرجل، وهو ربع
دية النفس، وهكذ.
(مسألة ٣٨): المعيار في بلوغ الثلث وعدمه على وحدة الجناية عرفاً وتعدده، فإذا كان قطع الاربع الاصابع دفعة واحدة عرفاً كانت الجناية أكثر من الثلث وثبت الرد، أما إذا كان متفرقاً بحيث تعد جنايات متعددة فكل جناية دون الثلث ولا ردّ فيه.
(مسألة ٣٩): لا يشترط في القصاص في الاطراف التساوي في السلامة والعيب، فيقتص للمعيبة بالسليمة وللسليمة بالمعيبة بلا رد. نعم إذا كانت اليد شلاء فالأحوط وجوباً عدم القصاص فيه، بل الدية وهي ثلث دية اليد الصحيحة.
(مسألة ٤٠): تقطع اليد باليد، فإن كان للجاني مماثل للمقطوع من حيثية اليمين واليسار كان هو المقدم في القصاص، فتقطع اليمين باليمين واليسار باليسار، وإلا سقطت المماثلة في ذلك، فإن لم يكن للجاني يد قطعت رجله مع مراعاة المماثلة من حيثية اليمين واليسار مع الامكان، ويسقط مع التعذر.
(مسألة ٤١): إذا فقأ الاعور عيناً واحدة من ذي عينين كان له القصاص، فيفقأ عينه وإن صار أعمى. وأظهر من ذلك ما لو فقأ عين أعور مثله.
(مسألة ٤٢): إذا فقأ صحيح العينين العين الصحيحة من الاعور تخير المجني عليه بين القصاص من إحدى عيني الجاني مع أخذ نصف دية الانسان وأخذ دية تامة من دون قصاص. نعم لو كان عور الاعور لجناية جان فالأحوط وجوباً مع اقتصاصه عدم أخذ فاضل الدية.
(مسألة ٤٣): في إذهاب الرؤية من العين مع بقائها القصاص إن أمكن من دون تعد على الجاني بأكثر مما جنى ومع خوف التعدي تتعين الدية. وكذا الحال في جميع منافع الاعضاء إذا ذهبت مع بقاء العضو سالم.
(مسألة ٤٤): يثبت القصاص في إزالة الشعر إذا لم يكن فيه إفساد لمحله بل كان ينبت ثاني. وكذا إذا كان فيه إفساد لمحله بحيث لا ينبت ثانياً إن أمكن القصاص، وإلا تعينت الدية.
(مسألة ٤٥): يثبت القصاص في قطع الذكر من الرجل والفرج من المرأة بالمثل، أما لو قطع الرجل فرج المرأة أو المرأة فرج الرجل فلا قصاص، بل تتعين الدية. نعم إذا قطع الرجل فرج امرأته وامتنع عن دفع الدية كان للمرأة القصاص بقطع ذكره.
(مسألة ٤٦): يثبت القصاص في الاسنان ذات الاُصول الثابتة في أصل الفك. ولا يسقطه نباتها بعد ذلك وإن عادت كحالها الاول. نعم الأحوط وجوباً عدم القصاص إذا كانت لغير البالغ، لما تقدم في شروط القصاص. وأما الاسنان النابتة في اللحم غير ذات الاُصول - المسماة بالاسنان اللبنية - فالظاهر وجوب القصاص فيها بمثلها إذا كان الجاني والمجني عليه كبيرين، وإن كان الفرض نادر. أما القصاص عنها بالسن الاصلية فهو لا يخلو عن إشكال. والأحوط وجوباً عدمه، والرجوع إلى الدية سواءً عادت أم لم تعد.
(مسألة ٤٧): لابد من المماثلة في قصاص الاسنان، فلا يقتص لاسنان المقدم بالطواحن ولا العكس، ولا يقتص بشيء منها بالانياب ولا العكس، بل الأحوط وجوباً عدم الاقتصاص للعليا بالسفلى وبالعكس. بل وعدم الاقتصاص للثنيتين المتوسطتين بالرباعيتين اللتين على جانبيهما وبالعكس، بل يرضى في جميع ذلك بالدية. نعم الظاهر عدم إخلال اختلاف الجانب بالمماثلة عرف، فيقتص لما في الجانب الايمن بما في الجانب الايسر وبالعكس. وإن كان الأحوط وجوباً الحفاظ على المماثلة في الجانب مع الامكان وعدم الاخلال بها إلا مع التعذر كما إذا لم يكن للجاني سن مماثل في الجانب الذي اعتدي على مثله في
المجني عليه. ويجري جميع ذلك في الاصابع وفي جميع الاطراف.
(مسألة ٤٨): إذا قطع شيء من جسد الانسان أو شق ثم اُلصق واُعيد إلى ما كان عليه قبل الجناية - كما يشيع ذلك في عصورنا - فالظاهر سقوط القصاص. بل يشكل ثبوت الدية، ويحتمل الرجوع للحكومة التي يأتي الكلام فيها في الديات، فاللازم التصالح. نعم إذا اُصلح النقص بأجنبي لم يمنع من القصاص، كما لو فقأ عينه فزرع عين حي أو ميت بدله، أو قطعت شحمة اُذنه فوضع بدلها لحمة من بدنه أو بدن غيره بعملية تجميل أو نحو ذلك.
(مسألة ٤٩): إذا جنى بما يستوجب القطع أو الشق ثم اقتص منه فأراد إصلاحة بإلصاقه وإعادته على ما كان عليه قبل القصاص لم يمكّن من ذلك، ولو فعل اُعيد القصاص عليه لابقاء النقص. نعم في منعه من إصلاح النقص بأجنبي - نظير ما تقدم في المسألة السابقة - إشكال، والاظهر العدم.
(مسألة ٥٠): إذا قطع منه شيء واقتص لنفسه ثم تسنى للمجني عليه أن يعيد ما قطع منه بنفسه ورجع الحال إلى ما كان عليه قبل الجناية، فإن كان يعلم قبل الاقتصاص بقدرته على الاصلاح وحصوله منه ثم اقتص بنفسه كان عليه القصاص، وإن لم يعلم بذلك أو وكّل شخصاً بالقصاص ولم يباشره فلا قصاص عليه، بل الدية إن كان قد اقتص بنفسه جاهلاً بالحال. وإن قام غيره مقامه في الاقتصاص فلا دية عليه أيض، بل يتحملها المباشر، إلا أن يكون تابعاً للامام فتكون على بيت مال المسلمين. نعم إذا كان المجني عليه غارّاً لمطالبته بالقصاص مع علمه بحصول الاصلاح كان لمن يؤدي الدية الرجوع بها عليه. وعلى كل حال ليس للمقتص منه منع المجني عليه من الاصلاح، فضلاً عن أن يلزمه بعد حصول الاصلاح بإرجاع الحال إلى ما كان قبله.
(مسألة ٥١): لا يثبت القصاص في الجراح والشجاج مع انضباطها وعدم
كون القصاص معرضاً للنفس للهلاك أو معرضاً للعضو التلف أو الضرر.
(مسألة ٥٢): لا يثبت القصاص في الجرح الواصل للجوف ولا الناقل للعظم عن محله، ولا الواصل لاُم الرأس، ولا الهاشم للعظم.
(مسألة ٥٣): لا يثبت القصاص في كسر العظم حتى كسر الذراع على الأحوط وجوب.
(مسألة ٥٤): في الجراح والشجاج التي يثبت فيها القصاص لابد من مساواة القصاص للجناية طولاً وعرضاً وعمقاً وتكفي المساواة العرفية. كما أنه يجوز الاقتصاص بالاقل. وفي استحقاق الدية للزائد إشكال.
(مسألة ٥٥): إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية عليه بوجه غير متوقع لطوارئ خارجية فمات أو تلف عضو منه أو نحو ذلك فلا قصاص له ولا دية. وكذا إذا سرت الجناية بنفسها بوجه غير متوقع لا لطوارئ خارجية وكان القصاص بأمر الامام أو الحاكم الشرعي. وأما إذا لم يكن بأمره فلا قصاص، وفي سقوط الدية للسراية إشكال، فاللازم التصالح.
(مسألة ٥٦): في ثبوت القصاص في الضرب بالسوط وغيره، وفي اللطمة ونحوها إشكال، والأحوط وجوباً الاقتصار على الدية.
خاتمة
فيها مسائل..
الاُولى: إذا لجأ الجاني لحرم مكة المعظمة لم يقتص منه في النفس ولا في الجراح ولا في غيره، بل لا يبايع ولا يشارى ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم حتى يخرج منه. نعم إذا جنى في الحرم اقتص منه فيه. ولا يلحق بالحرم المذكور
حرمُ المدينة المشرفة ولا مشاهد الائمة (عليهم السلام) ، إلا أن يلزم من القصاص فيها هتكه، فيحرم.
الثانية: يستحب العفو عن القصاص في النفس والطرف وغيرهم، كما حثّ على ذلك الكتاب المجيد وتظافرت به الاخبار، قال تعالى:(وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم). وفي الحديث: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: (فمن تصدق به فهو كفارة له) قال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفى عنه من جراح أو غيره». ويتأكد ذلك في النادم التائب، فإن في الندم وتأنيب الضمير من الالم النفسي ما قد يزيد على العقاب البدني. وخصوصاً إذا استسلم للقصاص الذي فيه من كسر النفس والاقدام على تحمل المشقة ما يطفئ غضب المعتدى عليه ويشفي غيضه وما يستحق به المستسلم للشكر الجزيل والجزاء الجميل.
الثالثة: إذا عفا من بيده القصاص عن القصاص فليس له الرجوع في ذلك، لأن حقه قد سقط بالعفو ولا يعود بعد سقوطه، قال تعالى: (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم)، وعن الامام الصادق (عليه السلام) في تفسير هذه الاية أنه قال: «هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي، فله عذاب أليم، كما قال الله عزوجل».
القسم الثاني
في الديات
الدية هي المال المفروض تداركاً للجناية الواردة على النفس أو البدن. وهي تثبت بالاصل في مورد الخط، ومع العمد في مورد لا قصاص فيه. كما تثبت شرعاً بدلاً عن القصاص في مورد تعذره، وتثبت بالتراضي بدلاً عن القصاص مع إمكانه، كما يتضح مما تقدم.
ويقع الكلام فيها في ضمن فصول.
الفصل الاول
في دية النفس
(مسألة ٥٧): دية قتل المسلم عمداً أحد اُمور..
الأول: مائة من الابل. ولابد من كونها مسنة. والأحوط وجوباً أن تكون داخلة في السنة السادسة، وأن تكون فحولة لا إناث.
الثاني: مائتان من البقر. ويكفي فيه ما يصدق عليه أنه بقر. وإن كان الأحوط استحباباً أن تكون إناثاً مسنّة، وهي الداخلة في السنة الثالثة.
الثالث: ألف من الغنم. ويكفي فيه ما يصدق أنه شاة.
الرابع: ألف دينار ذهب. وقد تقدم في كتاب الزكاة أن الدينار أربعة
غرامات وربع تقريب، فتكون الدية أربعة كيلوات من الذهب وربع الكيلو تقريب.
الخامس: عشرة آلاف درهم فضة. وقد تقدم في كتابي الزكاة واللقطة أن الدرهم ثلاثة غرامات إلا ربع عشر الغرام تقريب، فتكون الدية ثلاثين كيلواً إلا ربع الكيلو من الفضة تقريب.
السادس: مائتا حلّة، وكل حلة ثوبان إزار ورداء. والأحوط وجوباً الاقتصار على برود اليمن.
(مسألة ٥٨): الأحوط وجوباً الاقتصار في كل خصلة من خصال الدية الستة على من يناسبه، فيؤخذ من أهل الابل - وهم أهل البوادي - الابل، ومن أهل البقر البقر، ومن أهل الغنم الغنم، ومن أهل الدنانير الدنانير، ومن أهل الدراهم الدراهم، ومن أهل الحلل الحلل، وإن كان بعض الناس من أهل أكثر من نوع واحد خيّر بينهم. نعم من لم يكن من أهل شيء من هذه الخصال كأهل المدن في زماننا - يتخير بين الخصال الستّ.
(مسألة ٥٩): في مورد ثبوت التخيير فالذي يخير هو الجاني ومن يقوم مقامه ممن يكلف بدفع الدية، لا من يستحق الدية. نعم إذا ثبتت الدية بالصلح بدل القصاص أمكن جعلها على وجه آخر، كما يمكن الزيادة على الدية.
(مسألة ٦٠): دية العمد يؤديها الجاني نفسه. نعم إذا ثبتت بالصلح بدل القصاص أمكن أن تجعل على غيره.
(مسألة ٦١): تؤدى دية العمد في سنة. والمراد بذلك أنها تؤدى في سنة من حين ثبوتها لا من حين حصول القتل. نعم إذا ثبتت بالصلح بدل القصاص أمكن تحديد مدة أدائها على خلاف ذلك.
(مسألة ٦٢): تقدم في أول الكلام في القصاص أن الخطأ على قسمين..
الأول: شبه عمد. ويتحقق بما إذا قصد إصابة المجني عليه بما لا يوجب القتل عادة، من دون قصد للقتل إذا صادف حصول القتل به.
الثاني: خطأ محض. وهو الذي لا يقصد به إصابة المجني عليه، بل يصيبه من دون قصد. وفيهما معاً الدية دون القصاص.
(مسألة ٦٣): دية شبه العمد هي الخصال الست المتقدمة، إلا أن الأحوط وجوباً أن تكون الغنم فيها ذكران. كما أن أسنان الابل فيها تختلف فتتردد بين وجهين..
الأول: أن تكون ثلاثاً وثلاثون منها حِقَّة - وهي الداخلة في السنة الرابعة - وثلاث وثلاثون جَذَعة - وهي الداخلة في السنة الخامسة - وأربع وثلاثون ثنيَّة - وهي التي ولدت بطنين - كما ان الأحوط وجوباً أن تكون كلها حامل.
الثاني: أن تكون أربعون منها حامل بين الثنية، وهي ولدت بطنين، كما سبق، وبازل عامها - وهي الداخلة في السنة التاسعة - وثلاثون بنت لبون - وهي الداخلة في السنة الثالثة - وثلاثون حقة. ويحسن مع ذلك الاحتياط بالصلح.
(مسألة ٦٤): دية شبه العمد يؤديها الجاني نفسه، كدية العمد، فإن امتنع من أدائها أو مات ثبتت في ماله، فإن لم يكن له مال كانت كسائر الديون الثابتة في ذمته.
(مسألة ٦٥): دية الخطأ المحض هي الخصال الست المتقدمة، إلا أن الأحوط وجوباً في أسنان الابل فيها أن تكون ثلاثون حقة - وتقدم شرحها - وثلاثون ابنة لبون، وعشرون ابن لبون - وهما ما يدخل في السنة الثالثة - وعشرون بنت مخاض، وهي الداخلة في السنة الثانية. ويمكن التراضي على غير ذلك.
(مسألة ٦٦): دية الخطأ المحض في القتل والاطراف والجروح وغيرها
على العاقلة، وهي عشيرة الجاني. على ما يأتي توضيحه في محله.
(مسألة ٦٧): تؤدى دية قتل الخطأ في ثلاث سنين من حين القتل، من دون فرق بين شبه العمد والخطأ المحض.
(مسألة ٦٨): إذا وقع القتل في حرم مكة المعظمة أو في الاشهر الحرم كانت الدية مغلظة، وهي دية وثلث من دية المقتول في غيره، رجلاً كان أو امرأة. ويختص ذلك بدية القتل ولا يعم دية الاطراف والجروح وغيرهم. ولا يلحق بحرم مكة حرم المدينة المنورة ولا غيره من الاماكن المقدسة، كالمساجد والمشاهد المشرفة.
(مسألة ٦٩): دية المرأة نصف دية الرجل من جميع الخصال الست المتقدمة. ويجري فيها التغليظ المتقدم إذا قتلت في الحرم أو في الاشهر الحرم.
(مسألة ٧٠): يستثنى من ثبوت الدية في قتل المسلم خطأ ما إذا قتل في أرض الكفر بتخيل كونه كافر، فإنه لا تثبت به الدية حينئذٍ وتثبت به الكفارة لا غير.
(مسألة٧١ ): دية ولد الزن، من الابوين معاً إذا حكم بإسلامه تبعاً لابويه أو لانه أظهر الاسلام ثمانمائة درهم، ودية المرأة على النصف من ذلك. ويجري فيهما التغليظ المتقدم. وأما ديات الاعضاء والجروح ونحوها فإنها تنسب للدية المذكورة بنسبة دية أعضاء وجروح غيره لديته، فدية عينه مثلاً أربعمائة درهماً ودية إصبعه ثمانون درهم، وهكذ. وأما إذا كان الزنا من أحد الابوين دون الآخر فدية الولد دية الولد الشرعي.
(مسألة ٧٢): دية الذمي ثمانمائة درهم، ودية المرأة على النصف، ويجري فيهما التغليظ المتقدم، وعلى ذلك تنسب ديات الاعضاء والجروح ونحوه، نظير ما تقدم في المسألة السابقة.
(مسألة ٧٣): لا دية لكافر غير ذمي.
(مسألة ٧٤): إذا أدّب الزوج زوجته تأديباً مشروعاً بما لا يوجب القتل عادة فصادف موتها فعليه ديته. وكذا الولي إذا أدّب المولى عليه.
(مسألة ٧٥): تقدم في كتاب الاجارة أن الطبيب ضامن ما لم يتبرأ من الضمان. لكن ذلك يختص بما إذا اُوكل العلاج له. أما إذا اُذن له في وجه خاص، فقام به ولم يتجاوزه، فأدّى ذلك إلى التلف، فلا ضمان عليه مطلق، كما لو اُذن له في شق خراج في بدنه فشقّه فمات بسبب الشق بوجه غير متوقع، فإنه لا دية حينئذٍ. نعم إذا لم يستند التلف لاصل الشق، بل لخصوصية فيه غير مأذون فيها بالخصوص اختارها بمقتضى اجتهاده توقف عدم ضمانه على براءته من الضمان، كما إذا استند لكيفية الشق أو لعدم ربطه بعد تنظيف الخراج أو نحو ذلك. وكذا يضمن إذا كان غارّ، بأن أظهر أنه من أهل الخبرة والمعرفة ولم يكن كذلك، بل لا تنفع البراءة من الضمان حينئذٍ. كما أنه لو كان العمل مما لا يستبعد معه التلف كان عليه القصاص حينئذٍ.
الفصل الثاني
في ديات قطع الاعضاء
ونحوها مما في البدن
تمهيد: في الارش والحكومة
في كل اعتداء على الانسان المحترم الدم الدية. فإن كان لذلك الاعتداء مقدر شرعاً مستفاد من دليل عام أو خاص عمل عليه، وإن لم يثبت لذلك مقدر شرعاً ففيه الارش، وقد يسمى بالحكومة. والأحوط وجوباً في تحديده الرجوع لحكمين عادلين يحكمان به. فإن اتفق الطرفان على تعيينهما فذاك، وإن اختلفا رجعا للحاكم الشرعي في تعيينهم، ولابد أن يبتني حكم الحكمين على ملاحظة الدية
الشرعية المنصوصة للنفس والاطراف والجروح وغيره، ومقايسة غير المنصوص به حسبما يتوصل إليه اجتهادهما بعد إعمال منتهى طاقتهم. ولابد مع ذلك من التصالح بين الطرفين الجاني أو عاقلته والمجني عليه أو وارثه إما على الرجوع للحكمين قبل تحكيمهما أو على ما حكما به بعد تحكيمهما وصدور الحكم منهم.
إذا عرفت هذ، فيقع الكلام في هذا الفصل في ديات القطع المنصوصة وغيره. وهو يكون في اُمور..
الأول: الشعر:
(مسألة ٧٦): إذا اُزيل شعر اللحية من الرجل، فإن عاد ونبت ثانياً ففيه ثلث دية الرجل، وإن لم ينبت ففيه الدية كاملة.
(مسألة ٧٧): إذا اُزيل شعر الرأس من الرجل فإن نبت ففيه الارش والحكومة، وإن لم ينبت فالمشهور أن فيه الدية كاملة. والأحوط وجوباً الصلح.
(مسألة ٧٨): إذا اُزيل شعر رأس المرأة فإن نبت ففيه مهر نسائه، وإن لم ينبت ففيه ديته.
(مسألة ٧٩): إذا اُصيب الحاجب فذهب شعره ولم ينبت فديته نصف دية العين، وهو ربع الدية التامة، وفي بعضه بالنسبة. فإن نبت ففيه الارش والحكومة.
(مسألة ٨٠): في أبعاض الشعر المتقدم غير الحاجب الحكومة، سواء كان التبعيض في مساحة منبت الشعر أم في طول الشعر، كما إذا قصه وقصره. وكذا الحال في بقية شعر البدن كأهداب العينين وشعر العانة وغيرهم.
الثاني: العين:
(مسألة ٨١): إذا قلعت أو فقئت العين من شخص - رجل أو امرأة - كان له نصف ديته، وفي العينين معاً ديته كاملة. من دون فرق بين العين الصحيحة
والعمشاء والجاحظة والحولاء وغيره.
(مسألة ٨٢): في العين الصحيحة من الاعور ديته كاملة، وإذا كان عورُه بجناية جان عليها ففي ثبوت تمام الدية أو نصفها وجهان، والأحوط وجوباً التصالح.
(مسألة ٨٣): في العين القائمة إذا لم تكن مبصرة ثلث ديته.
(مسألة ٨٤): في شتر جفن العين الاعلى ثلث دية العين، وفي شتر جفنها الاسفل نصف دية العين. وكذا الحال في قطعهم.
(مسألة ٨٥): ليس في الاهداب شيء إذا اُصيبت مع الاجفان، وإنما يثبت فيها الارش - كما تقدم - إذا اُصيبت وحده.
(مسألة ٨٦): إذا اُصيب الجفن مع العين ثبت لكل ديته، ولا تتداخل الديتان.
الثالث: الانف:
(مسألة ٨٧): إذا قطع مارِن الانف - وهو ما لأن منه - كله من شخص ففيه ديته تامة، وكذا فيما زاد عليه حتى يستأصل كله. نعم مع تعدد الجناية بأن قطع شخص المارن أولاً ثم قطع هو أو غيره ما زاد عليه من الانف ثبتت الدية في المارن، وكان في الزائد الارش والحكومة.
(مسألة ٨٨): إذا قطع من شخص طرف الانف المشرف على الفم ففيه نصف ديته. وفي كل واحد من جانبيه وهو الظاهر من المنخر ثلثه. وكذا في إزالة الحاجز بين المنخرين، لكن مع التصالح عليه بين الطرفين على الأحوط وجوب.
(مسألة ٨٩): إذا نفذت نافذة في أحد المنخرين وبرئت ففيها عشر الدية، وإن لم تبرأ ففيها ثلث الدية.
الرابع: الاذن:
(مسألة ٩٠): في قطع الاُذن من أصلها من شخص نصف ديته، وفي قطع
الاُذنين معاً منه دية تامة. من دون فرق بين الاُذن الصماء وغيره.
(مسألة ٩١): إذا قطع بعض الاُذن ففيه من دية الاُذن بنسبة المقطوع لمجموع الاُذن. نعم يثبت ثلث دية الاُذن في قطع شحمته، وهي اللحمة التي في أسفله.
(مسألة ٩٢): في خرم الاُذن وثقبها الارش والحكومة.
الخامس: الشفة:
(مسألة ٩٣): إذا استؤصلت الشفتان معاً من شخص ففيهما ديته تامة.
(مسألة ٩٤): إذا استؤصلت الشفة العليا وحدها من شخص ففيها نصف ديته. وإذا قطع بعضها ففيه من الدية المذكورة بنسبة المقطوع لمجموع الشفة.
(مسألة ٩٥): إذا شقت الشفة العليا حتى بانت منها الاسنان ثم عولجت والتأمت وبرئت ففيها خمس ديته، وإن لم تلتئم وبقي شينها قبيحاً ففيها خمس ديتها وثلث الخمس. وفيما عدا ذلك منها الحكومة والارش.
(مسألة ٩٦): إذا استؤصلت الشفة السفلى وحدها من شخص ففيها ثلثا ديته، وإذا قطع بعضها ففيه من الدية المذكورة بنسبة المقطوع لمجموع الشفة.
(مسألة ٩٧): إذا شقت الشفة السفلى حتى بانت الاسنان منها ثم التأمت بالتداوي والعلاج ففيها خمس ديته، وإن لم تلتئم وبقي شينها قبيحاً ففيها نصف ديته. وفيما عدا ذلك منها الحكومة والارش.
(مسألة ٩٨): إذا اُصيبت الشفة فتقلصت من دون جرح أو قطع ففيها الحكومة.
السادس: اللسان:
(مسألة ٩٩): في لسان الصحيح ديته كاملة. وفي لسان الأخرس ثلث ديته. وفي أبعاضهما الحكومة.
(مسألة ١٠٠): في قطع لسان الطفل الذي لم يتكلم الدية كاملة، إلا أن يعلم بأنه أخرس ففيه ثلث الدية.
السابع: الاسنان:
(مسألة ١٠١): في الاسنان بجموعها إذا اُسقطت من الانسان ديته كاملة.
(مسألة ١٠٢): تقسم الدية على ثمانية وعشرين سناً المقدم منها - وهو الانياب الاربعة وما بينها - اثنى عشر، والمؤخر منها - وهو الاضراس - ستة عشر. لكل واحد من المقدم نصف عشر الدية تكون بحساب الدنانير خمسين دينار، ومجموعها ستمائة دينار. ولكل واحد من المؤخر ربع عشر الدية تكون بحساب الدنانير خمسة وعشرين دينار، ومجموعها أربعمائة دينار.
(مسألة ١٠٣): يكفي في ثبوت دية السن انفصال ما ظهر منه خارج اللثة بكسر أو نشر أو نحوهم، ولا يشترط فيه قلعه من أصله. وفي انفصال بعض ما ظهر منه بكسر ونحوه الارش والحكومة.
(مسألة ١٠٤): من نقصت أسنانه خلقة فقلعت كلها نقصت ديتها بالنسبة.
(مسألة ١٠٥): في الاسنان الزائدة الارش والحكومة، سواء قلعت مع الاصلية أم وحده.
(مسألة ١٠٦): إذا ضربت السن انتظر بها سنة، فإن وقعت غرم الضارب ديته، وإن اسودت فعليه ثلثا ديته، وإن تغيرت بغير السواد أو لم تتغير ففيها الارش والحكومة.
(مسألة ١٠٧): إذا اُسقطت السن السوداء ففيها ربع ديته.
(مسألة ١٠٨): ما سبق يختص بدية الاسنان ذات الاُصول النابتة في الفك، وأما الاسنان النابتة في اللحم غير ذات الاُصول - المسماة بالاسنان اللبنية - فالظاهر
فيها الارض. والأحوط وجوباً تقديره لكل سن ببعير، من دون فرق بين نبات غيرها مكانها وعدمه. نعم إذا كان عدم نبات غيره ناشئاً عن خلل في الفك بسبب الجناية على السن، ففيه الارش والحكومة غير ما ثبت بسبب سقوط السن.
(مسألة ١٠٩): لو ثبّت مكان السن المقلوع سناً حقيقية - من إنسان أو حيوان - أو صناعية فجنى عليها جان فأزالها أو كسرها فعليه ضمان نقص ذلك، والمرجع فيه الصلح، ومع التشاح يرجع للحاكم الشرعي.
الثامن: اليد:
(مسألة ١١٠): في قطع كل يد من شخص نصف ديته، وفي اليدين معاً ديته تامة.
(مسألة ١١١): المدار في قطع اليد على العضو الخاص، المنتهي بالمنكب، سواء قطع من تمام الكف أم مما زاد عليه، بأن قطع مع الذراع أو مع العضد أو مع أبعاضهم، فتثبت دية اليد في ذلك كله من دون زيادة ولا نقيصة. نعم إذا قطعت الكف مثلاً فثبتت دية اليد ثم قطع الذراع بجناية اُخرى ففيه الارش والحكومة، وكذا في كل جناية اُخرى بعد قطع الكف.
(مسألة ١١٢): في شلّ اليدين معاً الدية، وفي شلّ إحديهما نصفه، كما هو الحال في القطع.
التاسع: الاصابع:
(مسألة ١١٣): في أصابع اليدين بتمامها من شخص ديته، وكذا في أصابع الرجلين.
(مسألة ١١٤): تقسم دية الاصابع على عشرة، فلكل إصبع عشر الدية.
(مسألة ١١٥): تقسم دية الابهام على مفصلين، ففي قطع المفصل الاعلى منهما وحده نصف دية الابهام، ولا تتم دية الابهام إلا بقطعه من أصله. وتقسم
دية بقية الاصابع على ثلاثة مفاصل، ففي قطع المفصل الاعلى وحده ثلث دية الاصبع، وفي قطع الثاني ثلثاه، ولا تتم دية الاصبع إلا بقطعه من أصله.
(مسألة ١١٦): إذا اوجبت الجناية شلل الاصبع ففيها ثلثا ديته.
(مسألة ١١٧): في فصل كل ظفر من اليد أو الرجل خمسة دنانير.
(مسألة ١١٨): في الاصبع الزائدة ثلث دية الاصبع الاصلية.
العاشر: الثديان:
(مسألة ١١٩): في ثدي المرأة نصف ديته، وفي الثديين معاً تمام ديته. وفي حلمة ثديها ربع ديته، وفي الحلمتين معاً نصف ديته.
(مسألة ١٢٠): في حلمة ثدي الرجل ثمن ديته، وفيما زاد عليها من ثديه الارش والحكومة.
الحادي عشر: الذكر:
(مسألة ١٢١): في قطع الذكر الدية تامة. من دون فرق بين الصغير والكبير، الشاب والشيخ، حتى العنين. نعم في ذكر الخصي ثلث ديته. وكذا في الذكر المشلول غير ذكر العنين.
(مسألة ١٢٢): يكفي في ثبوت الدية التامة قطع الذكر من الحشفة فما زاد. وأما قطع بعض الحشفة ففيه الارش والحكومة. والأحوط وجوباً كونه من الدية بنسبة المقطوع لتمام الحشفة.
الثاني عشر: البيضتان:
(مسألة ١٢٣): في قطع بيضة الرجل نصف ديته، وفي قطع البيضتين معاً دية تامة. والأحوط استحباباً التصالح بين الجاني والمجني عليه عن اليسرى بما بين نصف الدية وثلثيه، وعن اليمنى بما بين نصفها وثلثه.
(مسألة ١٢٤): في بيضتي الخصي إن كانتا موجودتين ثلث ديته.
الثالث عشر: قبل المرأة:
(مسألة ١٢٥): في قطع قبل المرأة ديتها تامة. من دون فرق بين السليمة والمعيبة - كالرتقاء والقرناء - والبكر والثيب والصغيرة والكبيرة.
(مسألة ١٢٦): المشهور أن في قطع كل من الشفرين الكبيرين من المرأة نصف ديتها وفيهما معاً ديتها تامة. لكن الظاهر أن فيهما الارش والحكومة. وكذا في قطع بقية أجزاء الفرج. لأن القبل ليس خصوص الشفرين الكبيرين، فلابد من توزيع الدية على تمام الاجزاء، ولا طريق للتوزيع المذكور إلا الحكومة.
الرابع عشر: الرجلان:
(مسألة ١٢٧): في قطع رجل واحدة من الشخص نصف ديته، وفي قطعهما معاً ديته كاملة.
(مسألة ١٢٨): المدار في قطع الرجل على العضو الخاص المنتهي في أصل الفخذ، سواء قطع من تمام القدم حيث مفصل الساق أم من الركبة أم من أصل الفخذ، نظير ما تقدم في اليدين. كما أن في قطع أصابعهما ما تقدم عند الكلام في الاصابع.
(مسألة ١٢٩): في شلّ الرجلين دية كاملة، وفي شلّ إحديهما نصف الدية، كما هو الحال في القطع.
(مسألة ١٣٠): في قطع كل عضو لايؤدي وظيفته - لشلل أو نحوه - ثلث الدية، كذكر الخصي وأنثييه ولسان الأخرس وعين الاعمى واليد الشلاء ونحوذلك. ويستثنى من ذلك ذكر العنين كما تقدم.
وهناك فروع كثيرة أعرضنا عنها خوف التطويل.
الفصل الثالث
في ديات الجرح والصدع والكسر ونحوها
(مسألة ١٣١): إذا جرح الرأس جرحاً خفيفاً يسلخ الجلد ولا يأخذ من اللحم ففيه جزء من مائة جزء من الدية، وهي بعير أو عشرة دنانير أو نحوهما من بقية أصناف الدية.
(مسألة ١٣٢): إذا جرح الرأس جرحاً يأخذ من اللحم يسيراً ففيه جزءان من مائة جزء من الدية.
(مسألة ١٣٣): إذا جرح الرأس جرحاً ينزل في اللحم ولا يبلغ الغشاء الرقيق الذي يحيط بالعظم ففيه ثلاثة أجزاء من مائة جزء من الدية.
(مسألة ١٣٤): إذا جرح الرأس جرحاً ينزل في اللحم حتى يصل الغشاء الرقيق الذي يحيط بالعظم ففيه أربعة أجزاء من مائة جزء من الدية.
(مسألة ١٣٥): إذا جرح الرأس جرحاً ينزل في اللحم حتى يصل إلى العظم ويوضحه ففيه خمسة أجزاء من مائة جزء من الدية.
(مسألة ١٣٦): إذا جرح الرأس جرحاً ينزل في العظم ويهشمه ففيه عشر الدية، فإن نقل العظم عن موضعه ففيه عشر ونصف يعني خمسة عشر جزء من مائة جزء من الدية.
(مسألة ١٣٧): إذا هشم عظم الرأس أو نقل من مكانه من دون جرح ففي جريان الحكم السابق عليه إشكال، والأحوط وجوباً فيه الرجوع للارش والحكومة.
(مسألة ١٣٨): إذا جرح الرأس جرحاً يبلغ اُم الدماغ - وهي جلدة رقيقة تجمع الدماغ تحت الجمجمة - ففيه ثلث الدية، وكذا الحال إذا نزل الجرح إلى جوف الدماغ.
(مسألة ١٣٩): إذا اُعطيت الدية في المسألة السابقة من الابل كفى فيها ثلاث وثلاثون، ويسقط الكسر وهو ثلث بعير، أما في غير الابل فلا يسقط الكسر حتى في البقر والغنم.
(مسألة ١٤٠): الجروح المتقدمة بمراتبها المختلفة إذا حصلت في الوجه كانت ديتها مثل ديتها إذا حصلت في الرأس، فالمراد بالرأس ما يقابل الرقبة لاخصوص منبت الشعر.
(مسألة ١٤١): إذا نفذ الجرح في الخد إلى فضاء الفم ولم يكن جرحاً واسعاً يرى منه داخل الفم فديته مائة دينار، فإن كان جرحاً واسعاً يرى منه داخل الفم فديته مائتا دينار، فإن التأم وبقي أثره وشينه كان فيه خمسون ديناراً للشين، فيكون مجموع ديته مائتين وخمسين دينار.
(مسألة ١٤٢): إذا اُبينت من الخد قطعة من اللحم بقدر الدرهم من دون أن تكون الاصابة مظهرة للعظم ففيها ثلاثون دينار.
(مسألة ١٤٣): إذا كان في الخد جرح غير نافذ فبرئ ففيه عشرة دنانير. لكن في استحقاقها بمجرد ذلك أو بشرط أن يبقى له أثر بعد البرء إشكال، فالأحوط وجوباً الصلح. وأما جرح الوجه في غير الخد فيلحقه حكم الجروح في الرأس بمراتبها السابقة كما تقدم.
(مسألة ١٤٤): إذا خرق السهم أو الطلقة الخد حتى نبتت في عظم الحنك كان فيها مائة وخمسون دينار، مائة منها لخرق الخد وخمسون لاصابة عظم الحنك. وكذا الحال في كل إصابة تبلغ العظم وتوضحه في الوجه فإن لها
خمسين ديناراً إذا التحمت من دون شين، فإن التحمت مع الشين زادت الدية للشين وقدرت الزيادة بستة دنانير وربع، ولكن الأحوط وجوباً فيها الصلح.
(مسألة ١٤٥): لو كسر الانف من دون أن يقطع منه شيء ومن دون أن تفقد بسببه حاسة الشم ففيه الحكومة، سواء جبر على غير عيب أم ل.
(مسألة ١٤٦): في الجناية على الرقبة بحيث تميل إلى أحد الجانبين وتقف بحيث لا يستطيع الانسان أن يلتفت نصف الدية. وأما في غير ذلك من الجنايات على الرقبة من جرح أو كسر أو غيرهما ففيه الارش والحكومة.
(مسألة ١٤٧): في كسر الظهر من شخص ديته كاملة، وكذا إذا أصيب فاحدودب أو تعذر بسببه الجلوس، نعم إذا كسر ثم جبر من غير عيب ففيه مائة دينار. ولو حصل بسببه عيب آخر ثبتت دية ذلك العيب.
(مسألة ١٤٨): لما كان الظهر والصلب عظاماً متصلة بانتظام فالمراد بكسرها ليس هو كسر عظم واحد منه، كما في كسر عظمي العضد والساق، بل فصلها على وجه يختلّ نظامها وبنحو يشبه كسر العظم الواحد، بحيث يصدق عرفاً أنه كسر.
(مسألة ١٤٩): في جرح الظهر جرحاً يظهر فيه العظم خمسة وعشرون دينار، فإن لم يظهر العظم ففيه الارش والحكومة.
(مسألة ١٥٠): الترقوة هي العظم الناتئ المعترض في أعلى الصدر بين وسط الرقبة والمنكب. وفي كسرها إذا جبرت من غير عيب أربعون ديناراً فإن نقل العظم عن موضعه كان فيه عشرون ديناراً زائداً على دية الكسر.
(مسألة ١٥١): صدع العظم عبارة عن شقه من دون أن ينفصل، وهو في المسمى في عرفنا بالصدع إذا عرفت هذا ففي صدع الترقوة اثنان وثلاثون دينار، وفي نقبها عشرة دنانير. والمراد بالنقب حفر العظم وإن لم يخرج من
الجانب الآخر ويكون ثقب.
(مسألة ١٥٢): في جرح الترقوة جرحاً يظهر فيه عظمها خمسة وعشرون دينار، فإن لم يخرج العظم ففيه الارش والحكومة.
(مسألة ١٥٣): في كسر الترقوة إذا لم تجبر أو جبرت على عيب الارش والحكومة.
(مسألة ١٥٤): في كسر كل ضلع من الاضلاع العليا المسامتة للقلب خمسة وعشرون دينار، وفي صدعه اثنا عشر ديناراً ونصف. وفي نقبه - بالمعنى المتقدم - ستة دنانير وربع، وفي نقله عن موضعه سبعة دنانير ونصف.
(مسألة ١٥٥): في الجرح الذي يظهر فيه عظم أحد الاضلاع المذكورة ستة دنانير وربع، فإن لم يظهر العظم ففيه الارش والحكومة.
(مسألة ١٥٦): في كسر كل ضلع من الاضلاع السفلى عشرة دنانير، وفي صدعه سبعة دنانير، وفي نقله عن موضعه خمسة دنانير، وفي نقبه - بالمعنى المتقدم - ديناران ونصف، وكذا في الجرح الذي يظهر فيه عظم أحد الاضلاع المذكورة، فإن لم يظهر العظم ففيه الارش والحكومة.
(مسألة ١٥٧): في رضّ الصدر إذا انثنى وتقوس أحد جانبيه مائتان وخمسون دينار، وإذا انثنى وتقوس كلا جانبيه خمسمائة دينار، وإذا رض من غير أن ينثني ففيه الارش والحكومة.
(مسألة ١٥٨): في رض كل كتف إذا انثنى وتقوس مائتان وخمسون دينار، وإذا رض كلاهما ففيه خمسمائة دينار. وإذا رض أحدهما أو كلاهما من غير أن ينثني ففيه الارش والحكومة.
(مسألة ١٥٩): في جرح الصدر أو الكتف حتى يظهر العظم خمسة
وعشرون دينار، فاذا لم يظهر العظم ففيه الارش والحكومة.
(مسألة ١٦٠): في كسر المنكب إذا جبر من غير عيب مائة دينار، وفي صدعه ثمانون دينار، وفي نقل عظامه عن موضعها بعد الكسر خمسون ديناراً زيادة على مائة دينار للكسر. وفي فك مفصله - المسمى في عرفنا بالفسخ - من دون كسر ثلاثون دينار. وفي نقبه - بالمعنى المتقدم - خمسة وعشرون دينار. وكذا في الجرح الذي يظهر به عظمه، فإن لم يظهر العظم ففيه الارش والحكومة.
(مسألة ١٦١): إذا رض المنكب فلم يجبر أو جبر على عيب فديته ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.
(مسألة ١٦٢): في كسر العضد إذا جبر من غير عيب خمس دية اليد مائة دينار، وفي نقل عظامه خمسون دينار، وفي نقبه - بالمعنى المتقدم - خمسة وعشرون دينار، وكذا في الجرح الذي يظهر عظمه، فإن لم يظهر العظم ففيه الارش والحكومة.
(مسألة ١٦٣): إذا كسر العضد ولم يجبر أو جبر على عيب ففيه الارش والحكومة. وكذا في صدعه من دون كسر.
(مسألة ١٦٤): في الجناية على الساعد - الذي هو عظم الذراع والذي له قَصَبتان - بالكسر وغيره الارش والحكومة، وإن كان المظنون أنه في كسره بكلا قصبتيه مائة دينار، وفي كسر إحداهما خمسون دينار، وفي جرحه حتى يظهر العظم خمسة وعشرون دينار، وفي إحدى القصبتين أربعون دينار. لكن ذلك لا يغني عن الاحتياط بالصلح أو بالحكومة في ذلك وفي بقية صور الجناية على الساعد، نعم لا إشكال في أن دية القرحة فيه التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.
(مسألة ١٦٥): في كسر المرفق، الذي هو المفصل بين العضد والذراع،
إذا جبر من غير عيب مائة دينار، فإن رضّ وبقي عيبه ففيه ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار وهي ثلث دية النفس.
(مسألة ١٦٦): في صدع المرفق ثمانون دينار، وفي نقبه - بالمعنى المتقدم - خمسة وعشرون دينار. وفي جرحه حتى يظهر العظم خمسة وعشرون دينار، وفي نقل عظامه خمسون دينار. وفي فك مفصله ثلاثون دينار.
(مسألة ١٦٧): المفصل بين الذراع والكف هو الرسغ أو الرصغ، وقد يسمى بالزند أيض، وفي رضّه إذا جبر على غير عيب مائة وستة وستون ديناراً وثلثا دينار، وهي ثلث دية اليد، فإن لم يجبر أو جبر على عيب ففيه الارش والحكومة.
(مسألة ١٦٨): دية الكف إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينار، ودية صدعها اثنان وثلاثون دينار، فإن جرحت حتى يظهر العظم فديتها خمسة وعشرون دينار، ودية نقل عظامها عشرون ديناراً ونصف دينار، ودية نقبها عشرة دنانير. والأحوط استحباباً الصلح لاحتمال زيادتها على ذلك وأن دية كسر الكف مائة دينار، ودية نقل عظامها خمسون دينار، وغير ذلك.
(مسألة ١٦٩): في كسر الاصابع الارش والحكومة.
(مسألة ١٧٠): في كل ورك إذا كسر ثم جبر من غير عيب خمس دية الرجل مائة دينار. فإن رض فلم يجبر أو جبر على عيب فديته ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.
(مسألة ١٧١): إذا صدع الورك ففيه ثمانون دينار، وفي نقل عظامه خمسون دينار، وإذا جرح حتى ظهر العظم ففيه خمسة وعشرون دينار، فإن لم يظهر العظم ففيه الارش والحكومة. وفي فكه ثلاثون دينار.
(مسألة ١٧٢): الفخذ بحكم الورك في جميع ما تقدم، وفك الفخذ هو عين فك الورك، لأن الورك لايتصل إلا بالفخذ.
(مسألة ١٧٣): في نقل عظم الفخذ خمسة وعشرون دينار.
(مسألة ١٧٤): في كل ركبة إذا كسرت ثم جبرت على غير عيب مائة دينار، وإن رضّت فلم تجبر أو جبرت على عيب ففيها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.
(مسألة ١٧٥): إذا انصدعت الركبة فديتها ثمانون دينار. فإن نقلت عظامها ففيها خمسون دينار، وفي نقبها خمسة وعشرون دينار، وكذا في جرحها إذا ظهر العظم فإن لم يظهر العظم ففيه الارش والحكومة،وفي فك الركبة ثلاثون دينار.
(مسألة ١٧٦): في كل ساق إذا كسرت ثم جبرت على غير عيب مائة دينار، ومع بقاء العيب فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.
(مسألة ١٧٧): إذا انصدعت الساق فديتها ثمانون دينار، وفي نقل عظامها خمسون دينار، وفي نقبها اثنا عشرة ديناراً ونصف دينار، وفي جرحها إذا ظهر العظم خمسة وعشرون دينار، فإن لم يظهر العظم ففيه الارش والحكومة.
(مسألة ١٧٨): في كل كعب إذا رض وجبر على غير عيب سدس دية النفس مائة وستة وستون ديناراً وثلثا دينار. والكعب هو قبة القدم. وفيما عدا ذلك من جناياته الحكومة.
(مسألة ١٧٩): في كل واحد من القدمين إذا كسرت ثم جبرت على غير عيب مائة دينار، فإن لم تجبر أو جبرت على عيب ففيها الحكومة.
(مسألة ١٨٠): في نقل عظام القدم خمسون دينار، وفي نقبها خمسة وعشرون دينار، وكذا في جرحها حتى يظهر العظم، فإن لم يظهر العظم ففيه الارش والحكومة، وكذا في غير ما تقدم من الجنايات على القدم وفي الجنايات على أصابعه إلى الارش والحكومة أيض.
(مسألة ١٨١): لو نفذت نافذة - برمح أو خنجر أو طلقة أو نحوها - في شيء من أطراف البدن - كاليد والرجل والرقبة - من دون كسر عظم ففيها مائة دينار، والمراد بالنفوذ أن تخترق العضو من جانب لآخر وتثقبه، أما مع كسر العظم فتضاف إليها دية كسره. ولا يدخل في ذلك ثقب الانف والاُذن، فقد تقدم التعرض لديتهما عند الكلام في دية قطع الانف والاُذن، وكذا لا يدخل في ذلك ثقب الخد فقد تقدم الكلام فيه في أوائل هذا الفصل.
(مسألة ١٨٢): إذا نفذت نافذة من إحدى جهات البدن إلى الجوف ففيها ثلث الدية، وإن اُعطيت من الابل كفى ثلاثة وثلاثون بعير، ويسقط الكسر، وهو ثلث بعير. والمراد بالجوف داخل الصدر والبطن.
(مسألة ١٨٣): إذا نفذت نافذة من أحد جانبي البدن للآخر، كما لو رماه في بطنه فخرجت الرمية من ظهره ففيها أربعمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، والأحوط وجوباً الاقتصار في ذلك على ما إذا أصابت البطن ولو من أحد الجانبين، أما في غير ذلك كما لو اخترقت الصدر والظهر فالأحوط وجوباً الرجوع للارش والحكومة.
(مسألة ١٨٤): إذا عيب شيء مما في الجوف من الامعاء أو غيرها بسبب الجناية المتقدمة في المسألتين السابقتين كان فيه الارش والحكومة زيادة على الدية المتقدمة فيهم. وكذا الحال لو عيب شيء مما في الجوف من دون جرح نافذ، فإن فيه الارش والحكومة.
(مسألة ١٨٥): إذا جرح الجسد - غير الرأس والرقبة - جرحاً يبلغ العظم ويظهره ففيه أربعون دينار، إلا ما تقدم في جروح الاعضاء كاليدين والرجلين وغيرهم، كما تقدم دية جروح الرأس والرقبة. وأما إذا لم يبلغ الجرح في الجسد العظم ففيه الارش والحكومة، وقد تقدم في أول الفصل جروح الرأس والرقبة.
(مسألة ١٨٦): إذا نفذت نافذة من الرمح أو الخنجر في شيء من أطراف البدن فديتها مائة دينار.
(مسألة ١٨٧): في كل فتق للجوف ثلث الدية - ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار - كفتق السرة والبيضة ونحوهما من مواضع البطن ومنافذه. وفي فتق كلتا البيضتين بجناية واحدة أربعمائة دينار، فإن كان الفتق ضخماً بحيث يمنع من المشي أو يوجب تشوهه شديداً بسبب تباعد الرجلين ففيه أربعة أخماس الدية ثمانمائة دينار.
(مسألة ١٨٨): في اللطمة في الوجه إذا اسود أثرها ستة دنانير، وإذا اخضر ثلاثة دنانير، وإذا احمر دينار ونصف وإن كانت في البدن فهي على النصف. وإن كانت في غير الوجه من الرأس ففيها الارش والحكومة. وكذا إذا كانت في الرقبة.
(مسألة ١٨٩): الظاهر عموم المسألة السابقة لغير اللطمة من أنحاء الضرب، كالوكزة والضرب بالسوط وبالخشبة ونحوه، بل الظاهر العموم للصدمة من دون ضرب. نعم يشكل العموم بحصول الاثر المذكور من غير صدمة، كما في العصر والعض والقرص وغيره، وحينئذٍ فالأحوط وجوباً ثبوت الارش والحكومة.
(مسألة ١٩٠): إذا لم يؤثر الضرب أحد الالوان الثلاثة المتقدمة ففيه الارش والحكومة.
(مسألة ١٩١): تشارك المرأة الرجل في جميع ما تقدم حتى تبلغ الجناية ثلث الدية، فإذا بلغ ثلث الدية صارت المرأة على النصف.
(مسألة ١٩٢): المقادير المتقدمة للجنايات المختلفة من الجروح والكسور وغيرها وإن قدرت تارة بالابل واُخرى بالدنانير، إلا أنها ترجع إلى نسبة المقادير المذكورة إلى مجموع الدية من جميع أصنافها المتقدمة في دية النفس، فإذ
ذكر في دية الجناية بعير مثلاً أجزأ ما يساوي عشرة دنانير من الذهب أو مائة درهم من الفضة أو بقرتان أو عشر شياه، وإذا ذكر في ديتها خمسون ديناراً مثلاً أجزأ ما يساوي خمسمائة درهم من الفضة أو خمس من الابل أو عشر بقرات أو خمسين شاة وهكذ. وليس التنصيص على خصوص بعض الاصناف إلا لذكره في بعض النصوص من دون إلزام به بخصوصه.
(مسألة ١٩٣): من افتض امرأة بالوطء أو بغيره وجب عليه مهر مثله، نعم لا مهر لها إذا كانت زانية بأن تكون راضية بالوطء من غير شبهة. وكذا إذا رضيت بإزالة بكارتها بغير الوطء. أما إذا أزال بكارتها الزوج بالوطء فليس لها إلا تمام المهر المسمى لها بالعقد. أما الوطء بعد زوال البكارة فقد تقدم حكمه في أواخر فصل المهر من كتاب النكاح.
(مسألة ١٩٤): في إفضاء المرأة ديته، والافضاء هو اتصال مجرى الحيض والغائط وانخرام الحاجز بينهم.
(مسألة ١٩٥): إذا كان المفضي للمرأة زوجها فإن كان بسبب غير الوطء ففيه الدية، وكذا إذا كان بسبب الوطء قبل أن تكمل تسع سنين وطلقه. نعم إذا كان طلاقها بعد أن خيط الجرح والتأم ففي ثبوت الدية إشكال واللازم الاحتياط. أما إذا لم يطلقها وأمسكها فلا شيء عليه. وكذا إذا كان الافضاء بسبب وطئها بعد إكمال تسع سنين فإنه لاشيء عليه أيضاً حتى لو طلقه. نعم لو تعمد إفضاءها فالظاهر ثبوت الدية مطلقاً في الصغيرة والكبيرة مع الطلاق وبدونه.
(مسألة ١٩٦): إذا وطأ الرجل زوجته قبل أن تبلغ تسع سنين فأفضاها كان عليه الانفاق عليها ما دامت حية حتى لو طلقه. بل وإن تزوجت على الأحوط وجوب. نعم لو خيط الجرح والتأم ففي وجوب الانفاق عليها إشكال، واللازم الاحتياط.
الفصل الرابع
في ديات المنافع
(مسألة ١٩٧): إذا أدّت الجناية إلى ذهاب العقل ففيه الدية كاملة. وإذا أدت إلى نقصه أو صار المجني عليه مجنوناً جنوناً إدوارياً ففيه الارش والحكومة.
(مسألة ١٩٨): إذا ذهب العقل بجناية لها دية بنفسها تداخلت ديتها مع دية ذهاب العقل وثبت الأكثر دية، فمثلاً إذا استند ذهاب العقل لضربة واحدة ثبتت دية ذهاب العقل وسقطت دية الضربة، أما إذا استند ذهاب العقل لضربات متعددة يثبت في مجموعها أكثر من دية ثبتت دية الضربات وسقطت دية ذهاب العقل، كما أنه لو بلغت دية الضربات دية تامة تداخلت مع دية العقل وثبتت دية واحدة. نعم إذا استند ذهاب العقل للضربة الاخيرة فقط ثبتت لكل ضربة من الضربات السابقة ديته، ولم يتداخل مع دية العقل إلا دية الضربة الاخيرة، فتسقط.
(مسألة ١٩٩): إذا نقص العقل بجناية ذات دية ثبت أكثر الامرين من دية تلك الجناية وأرش ما ذهب من العقل الثابت بمقتضى الحكومة.
(مسألة ٢٠٠): إذا علم بعدم عود العقل إلى ما كان عليه قبل الجناية وجبت الدية وكان على الجاني تسليمها بمجرد الجناية، وإن احتمل عوده انتظر به سنة من حين الجناية، فإن عاد في أثناء السنة فلا دية له، وتثبت دية الجناية إن كان لها دية مقدرة، وإن لم تكن لها دية مقدرة ثبت لها الارش والحكومة، وإن لم يعد العقل في أثناء السنة وجب على الجاني أداء الدية، فإن عاد العقل بعد السنة
لم يسترجع الجاني الدية.
(مسألة ٢٠١): إذا ذهب السمع كله ففيه الدية كاملة، وفي ذهاب سمع إحدى الاُذنين نصف الدية، وفي نقص السمع يثبت من الدية بنسبة الفائت لمجموع السمع، وفي عموم ذلك لما إذا كان السمع قبل الجناية ناقصاً عن المتعارف في إحدى الاُذنين أو في كلتيهما إشكال، فالأحوط وجوباً الصلح.
(مسألة ٢٠٢): إذا ادعى المجني عليه ذهاب السمع بالجناية فإن صدقه الجاني فذاك، وإن لم يصدقه اُجّل سنة وامتحن المجني عليه في أثنائها بأن يترصّد ويستغفل ويصاح به، يكرر عليه ذلك في السنة فإن سمع أو قامت البينة على أنه سمع لم يستحق الدية، وإلاّ استحلف واُعطي الدية.
(مسألة ٢٠٣): لابد في استحلافه على ذهاب سمعه كله من أن يحلف هو وخمسة أشخاص آخرون على ذلك، وإذا لم يحصل له العدد المذكور كرَّر هو الحلف بدل من ينقص منه، فان حلف معه أربعة حلف هو مرتين، وإن حلف معه ثلاثة حلف هو ثلاث مرات، وإن حلف معه اثنان حلف هو أربع مرات، وإن حلف معه واحد حلف هو خمس مرات، وإن لم يحلف معه أحد حلف هو ست مرات.
(مسألة ٢٠٤): إذا عاد السمع قبل السنة فلا دية، ويثبت الارش والحكومة، وإن عاد بعد السنة لم تسقط الدية.
(مسألة ٢٠٥): إذا ادعى المجني عليه نقص السمع في كلتا الاُذنين فإن صدقه الجاني فذاك، وإن لم يصدقه فإن أقام الجاني البينة فلا شيء له، وإن لم يقم البينة حلف المجني عليه، فإن ادعى نقص سدس سمعه حلف مرة واحدة، وإن ادعى نقص ثلث سمعه حلف مرة وحلف معه رجل، وإن ادعى نقص نصف سمعه حلف هو وحلف معه رجلان، وإن ادعى نقص ثلثي سمعه حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال، وإن ادعى نقص خمسة أسداس سمعه حلف هو
وحلف معه أربعة رجال، وإن لم يكن معه من يتمم يمينه ضوعف عليه اليمين بقدر الناقص. والمدار في نقص السمع على المسافة.
(مسألة ٢٠٦): إذا ادعى المجني عليه نقص سمع إحدى الاذنين قيست بالاضافة إلى الاُذن الصحيحة، فيثبت له من الدية بنسبة نقص سمع المعيبة عن سمع الصحيحة. وكيفية الاختبار: أن تسد التي اُصيبت سداً جيد، ثم يضرب له بالجرس من إحدى الجهات الاربع ويبعد عنه صاحب الجرس حتى ينتهي إلى أقصى مسافة يدعي السمع فيها فإن صدقه الجاني، وإلا عيّن الموضع الذي يدعي انه منتهى سمعه وضرب له الجرس من بقية الجهات الاربع، فإن تساوت المسافة التي يدعي السمع فيها صدق، وإن اختلفت كذب، وتعاد عليه التجربة حتى تتفق المسافة التي يدعيها من الجهات الاربع. وحينئذٍ تسدّ الاُذن الصحيحة سداً جيداً وتجري التجربة المتقدمة في الاُذن المصابة، فتقاس المسافتان، ويعطى من الدية بنسبة نقص مسافة السمع في الاُذن المصابة عن مسافة السمع في الاُذن الصحيحة، لكن بعد اليمين، فإن كان النقص بمقدار السدس حلف مرة، وإن كان بمقدار سدسين حلف مرة وحلف معه رجل آخر، فان لم يحلف معه رجل حلف مرتين، وهكذا لكل سدس رجل يحلف معه أو يمين يكرره، نظير ما تقدم في المسألة السابقة. هذا مع احتمال تساوي الاُذنين في السمع، أما مع العلم باختلافهما فيه فالأحوط وجوباً الصلح.
(مسألة ٢٠٧): لابد في الاختبار المذكور في المسألة السابقة من عدم وجود ما يعيق امتداد الصوت من بعض الجهات، بأن يكون في مكان منبسط لاتختلف جهاته بالارتفاع والانخفاض، ويكون هادئاً ليس فيه ضجيج في بعض الجهات أو جميعها يمنع من سماع الصوت أو يوجب تشويشه، وأن يكون الهواء ساكناً لئلا يصرف الصوت إلى خصوص بعض الجهات أو يشوشه.
(مسألة ٢٠٨): إذا كان ذهاب السمع أو نقصه بجناية على البدن، كما لو ضربه على رأسه أو على اُذنه أو قطع اُذنه أو اُذنيه، تتداخل الجنايتان وتثبت دية أعظمهما على نحو ما سبق في ذهاب العقل بتفصيله.
(مسألة ٢٠٩): إذا ذهبت الرؤية من العينين معاً ففيها الدية كاملة، وفي ذهاب الرؤية من إحداهما نصف الدية. وفي نقص الرؤية منهما أو من إحداهما يثبت من الدية بنسبة الفائت لمجموع الرؤية. وفي عمومه لما إذا كانت الرؤية قبل الجناية ناقصة عن المتعارف في إحدى العينين أو في كلتيهما إشكال، فاللازم الاحتياط بالصلح.
(مسألة ٢١٠): إذا ادعى المجني عليه فقده للرؤية فإن صدقه الجاني فذاك، وإن لم يصدقه اختبر بأن يقابل بعينيه الشمس، فإن كان كاذباً لم يتمالك حتى يغمض عينيه وإن كان صادقاً بقيتا مفتوحتين. ويؤكد ذلك باليمين، فيحلف هو ويحلف معه خمسة رجال أو يكرر اليمين، على نحوما تقدم في السمع.
(مسألة ٢١١): تقدم في السمع أنه ينتظر به سنة، فإن عاد في أثنائها لم يستحق الدية وكان له الارش والحكومة، وإن لم يعد فيها استحق الدية، ولا يسقطها عوده بعد السنة، وفي جريان ذلك في الرؤية إشكال. ولا يبعد كون رجوع الرؤية مطلقاً كاشفاً عن عدم فقدها بالجناية فلا تستحق الدية، بل الارش، وإن كان الأحوط وجوباً مع الشك الصلح.
(مسألة ٢١٢): إذا ادعى المجني عليه نقصان الرؤية في عينيه مع، فإن علم بمقدار رؤيته قبل الجناية من حيثية المسافة قيست رؤيته بعد الجناية بالاضافة لرؤيته قبل الجناية، واُعطي من الدية بنسبة النقص من رؤيته قبل الجناية. وإن جهل مقدار رؤيته قبل الجناية قيست رؤيته بعد الجناية في المسافة برؤية من هم في سنِّه، واُعطي من الدية بنسبة نقص رؤيته عن رؤيتهم.
(مسألة ٢١٣): إذا ادعى المجني عليه نقصان الرؤية في إحدى عينيه قيست رؤية العين المصابة برؤية العين الصحيحة، واُعطي من الدية بنسبة نقص العين المصابة عن رؤية العين الصحيحة. هذا مع احتمال تساوي العينين في الرؤية. أما مع العلم باختلافهما فالأحوط وجوباً الصلح.
(مسألة ٢١٤): كيفية قياس الرؤية في العينين بسد إحداهما وفتح الاُخرى وقياس نظرها إلى الجهات الاربع على نحو ما تقدم في قياس السمع. ولابد فيه من أن لايكون في يوم غيم أو نحوه مما يضعف الرؤية، وأن لايكون في موضع تختلف جهاته في امتداد الرؤية على نحو ما تقدم هناك.
(مسألة ٢١٥): لابد مع الاختبار المذكور في كلتا العينين أو في إحداهما من اليمين لكل سدس من الرؤية من قبل المجني عليه أو ممن يحلف معه، على نحو ماتقدم في السمع.
(مسألة ٢١٦): إذا كان النقص في الرؤية من غير حيثية المسافة ففيه الارش والحكومة، كما لو حدثت غشاوة أو عمىً عن الالوان أو غير ذلك. ولابد فيه من الاثبات بالطرق العامة في الدعوى من البينة واليمين ونحوهما على ما يراه الحاكم الشرعي عند التخاصم.
(مسألة ٢١٧): إذا كان ذهاب الرؤية أو نقصها بجناية على البدن تداخلت الجنايتان على نحوما تقدم في ذهاب العقل وذهاب السمع.
(مسألة ٢١٨): إذا ذهب الشم كله من الانف من كلا المنخرين ففيه الدية كاملة، وفي عموم ذلك لما إذا كان الشم قبل الجناية ناقصاً عن المتعارف إشكال، فالأحوط وجوباً الصلح.
(مسألة ٢١٩): إذا ادعى المجني عليه ذهاب الشم كله فإن صدقه الجاني فذاك، وإلا اختبر بالحراق، بأن يحرق شيء ويدنى من أنفه، فإن دمعت عيناه
ونحّى رأسه فهو كاذب، وإلا صدّق. لكن لابد من ضم اليمين اليه من المجني عليه ومن غيره، أو مضاعفة اليمين عليه، على نحو ماتقدم في السمع.
(مسألة ٢٢٠): في ذهاب الشم من أحد المنخرين الارش والحكومة، نعم لو رجع إلى نقص نصف الشم ففيه الدية.
(مسألة ٢٢١): إذا ادعى المجني عليه ذهاب الشم من أحد المنخرين، فإن صدقه الجاني فذاك، وإن لم يصدّقه سُدَّ المنخر الصحيح سداً محكماً ثم يختبر المنخر المصاب بالحراق، نظير ماتقدم، فإن لم ترجع دعواه إلى نقص مقدار الشم كفى يمين واحد.
(مسألة ٢٢٢): إذا ادعى المجني عليه نقص الشم ففي تحديد مقدار النقص إشكال، فاللازم الرجوع للارش والحكومة بعد إثبات حدوث النقص بالطرق العامة في الدعوى.
(مسألة ٢٢٣): إذا كان ذهاب الشم أو نقصه بجناية على البدن تداخلت الجنايتان على النحو المتقدم في المنافع السابقة.
(مسألة ٢٢٤): إذا ذهب النطق كله ففيه الدية كاملة. وإذا ذهب بعضه ثبت بعضها بالنسبة.
(مسألة ٢٢٥): إذا ادعى المجني عليه ذهاب النطق كله، فإن صدقه الجاني فذاك، وإن لم يصدقه فإن كانت الجناية بضربه على هامته ضرب على لسانه بإبرة، فإن خرج الدم أحمر فهو كاذب، وإن خرج أسود فهو صادق. وإن كانت الجناية بنحو آخر كان على الحاكم اختباره بما يراه دليلاً وإجراء حكم التداعي العام، وعلى كل حال لابد من اليمين من المجني عليه ومن غيره أو مضاعفة اليمين عليه على نحو ما تقدم في السمع.
(مسألة ٢٢٦): النقص في النطق يقاس على حروف المعجم، فتقسم الدية
عليه، ويعطى المجني عليه من الدية بنسبة مالايفصح به منه.
(مسألة ٢٢٧): الظاهر أن حروف المعجم التي تقسم عليها الدية ثمانية وعشرون حرفاً - كما هو المشهور، ويقتضيه النظر في النصوص - بجعل الهمزة فيها دون الالف، لانها هي التي تنطق بنفسها عرف، وأما الالف فهي وإن عدت من الحروف عند أهل العربية، إلا أنها لاتنطق بنفسها بل تقوم بغيرها نظير قيام الحركة بالحرف، ونظير قيام الواو والياء اللينتين به، لكن يحسن مع ذلك الاحتياط بالصلح.
(مسألة ٢٢٨): لو كان المجني عليه لايحسن العربية، وحروف معجم لغته مخالفة لحروف معجم اللغة العربية أشكل قياس نقص نطقه على حروف معجم اللغة العربية، بل الأحوط وجوباً الرجوع فيه للارش والحكومة.
(مسألة ٢٢٩): إذا ادعى المجني عليه نقص النطق، فإن صدقه الجاني فذاك، وإن لم يصدقه فلابد من يمينه مع يمين غيره أو مضاعفة اليمين عليه على نسبة ما نقص من كلامه، على نحو ماسبق في نقص السمع.
(مسألة ٢٣٠): إذا كان ذهاب النطق أو نقصه بجناية على البدن تداخلت الجنايتان على نحو ماتقدم في ذهاب العقل.
(مسألة ٢٣١): في ذهاب الذائقة أو نقصها بحيث لايميز الطعوم أو بعضها الارش والحكومة، ويرجع في طريق إثبات ذلك للطرق العامة في الدعوى، ولو كان ذلك بجناية على البدن تداخلت الجنايتان على نحو ماتقدم.
(مسألة ٢٣٢): في ذهاب الصوت كله حتى مثل البحّة والغنّة الدية كاملة، وفي نقصه وعيبه الارش والحكومة. ولو كان ذلك بجناية على البدن تداخلت الجنايتان، نظير ماتقدم.
(مسألة ٢٣٣): في الجناية على الرجل الموجبة لعدم سيطرته على بوله
أو على غائطه الدية كاملة، وكذا لو أوجبت الجناية فقد السيطرة عليهما مع، ويجري ذلك في المرأة إلا أن في سلس البول وحده لها ثلث ديته. ولو كان ذلك بجناية على البدن تداخلت الجنايتان نظير ما تقدم.
(مسألة ٢٣٤): إذا اوجبت الجناية على الرجل عجزه عن الجماع كان فيها الدية كاملة. وإن أوجبت له عدم إنزال المني ففيها الارش والحكومة.
(مسألة ٢٣٥): من داس بطن إنسان حتى أحدث عمداً كان عليه القصاص أو يدفع ثلث الدية، وله اختيار أيهما شاء لا للمجني عليه. أما لو كان ذلك خطأ فعليه ثلث الدية لاغير، والأحوط وجوباً الاقتصار في الحدث على الغائط وحده أو هو مع البول، دون الريح والبول من دون غائط، بل المرجع فيهما الارش والحكومة.
(مسألة ٢٣٦): تشارك المرأة الرجل في ديات المنافع المتقدمة مالم تبلغ ثلث دية الرجل، فإذا بلغت ثلث الدية صارت المرأة على النصف من الرجل، نظير ما تقدم في الفصول السابقة.
الفصل الخامس
في دية الحمل والميت والحيوان
(مسألة ٢٣٨): إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون دينار، وإذا كان علقة فأربعون دينار، وإذا كان مضغة فستون دينار، وإذا صار فيه العظام فثمانون دينار، وإذا كسيت العظام لحماً فمائة دينار من دون فرق بين الذكر والاُنثى، فإذا تمت خلقته وولجته الروح كانت ديته دية النفس إن كان ذكراً فألف دينار، وإن كان اُنثى فخمسمائة دينار.
(مسألة ٢٣٩): تمكث النطفة في الرحم أربعين يوم، ثم تصير علقة فتمكث أربعين يوم، ثم تصير مضغة فتمكث أربعين يوماً فهذه مائة وعشرون يوماً ثم تكون عظاماً بعد ذلك، ثم تكسى لحم، فإذا تمّ للجنين خمسة أشهر فلابد أن يكون قد ولجته الروح، وليس المراد بولوج الروح ماتحسه الحامل من حركة الجنين في الشهر الرابع، بل مايكون بعد تمامية خلقته قرب الشهر الخامس.
(مسألة ٢٤٠): هل تتدرج الدية بتدرج المراتب المتقدمة، فإذا دخل في دور العلقة زاد على العشرين ديناراً دينارين دينارين حتى يتم دور العلقة في آخر الثمانين يوماً فتتم له الاربعون دينار، فإذا دخل في دور المضغة زاد دينارين دينارين حتى يتم دور المضغة في آخر المائة والعشرين يوم، فتتم له الستون ديناراً وهكذ، حتى تتم المائة أول، بل تنتقل الدية بين المراتب الخمس دفعة واحدة، فتزيد عشرين عشرين ديناراً حتى تتم المائة؟ وجهان، واللازم الاحتياط بالصلح.
(مسألة ٢٤١): لافرق في ثبوت دية الجنين بين الجناية عليه بإسقاطه حياً ثم يموت وبما يقتضي موته في بطن اُمه ثم سقوطه ميتاً أو موتها قبل سقوطه ولو بسبب آخر.
(مسألة ٢٤٢): إذا كان الحمل أكثر من واحد فلكلٍّ ديته.
(مسألة ٢٤٣): إذا قتلت المرأة وهي حبلى فمات جنينها ولم يعلم أنه ذكر أو اُنثى فديته نصف دية الذكر ونصف دية الاُنثى.
(مسألة ٢٤٤): إذا أفزع شخص رجلاً عن زوجته حال الجماع فعزل عنها وأنزل المني خارج الفرج من دون أن يريد ذلك كان على المفزع لصاحب المني عشرة دنانير.
(مسألة ٢٤٥): إذا كان الجنين من الزنا فديته إذا كان نطفة ستة عشر درهم، وإذا كان علقة إثنان وثلاثون درهم، وإذا كان مضغة ثمانية وأربعون درهم، وإذا كان عظاماً أربعة وستون درهم، فإذا اكتسى اللحم فثمانون درهم، فإذا ولجته الروح فديته دية ولد الزنا ثمانمائة درهم إن كان ذكراً وأربعمائة درهم إن كان اُنثى، والذي يرث الدية هو الامام. هذا إذا كان الزنا من الابوين مع، أما إذا كان من أحدهما فقط فديته دية الحمل من غير زنى ويرثها غير الزاني من الابوين.
(مسألة ٢٤٦): دية الحمل بجميع مراتبه على القاتل في العمد وشبهه، وعلى عاقلته مع الخط، كما هو الحال في دية الانسان المولود.
(مسألة ٢٤٧): من قطع رأس ميت مسلم أو فعل به ما يوجب موته لو كان حياً فعليه مائة دينار ذكراً كان الميت أواُنثى ولاكفارة عليه، هذا إذا كان عامد. أما مع الخطأ فلا دية عليه، بل عليه كفارة قتل الخطأ لاغير.
(مسألة ٢٤٨): في قطع أعضاء الميت وجراحاته الدية بالنسبة، وهي عُشر ديته لو كان حي.
(مسألة ٢٤٩): لا يستحق وارث الميت ديته، بل تنفق في وجوه البر عنه، نعم إذا كان مديناً ديناً لاتفي به تركته وجب وفاء الدين من ديته، ولو لانه أفضل وجوه البر عنه، وكذا الحال في حجة الاسلام، بل الأحوط وجوباً تقديمها على الدين.
(مسألة ٢٥٠): إذا كان الميت ولد زنا مسلماً فديته عشر ديته إذا كان حياً ثمانون درهم، نظير ما تقدم في الحمل قبل أن تلجه الروح.
(مسألة ٢٥١): الأحوط وجوباً دفع دية الميت للحاكم الشرعي ليصرفها في وجوه البر عنه.
(مسألة ٢٥٢): دية الجنين والميت وإن سبق تقديرها بالدنانير، إلا أن المراد بها مايساوي نسبة الدية المذكورة للدية التامة من جميع أصناف الدية المتقدمة ولا تختص بالدنانير، نعم لا يجري ذلك في دية ابن الزن، بل هي تقدر بالدراهم لاغير.
(مسألة ٢٥٣): كل حيوان قابل للتذكية - سواءً كان مأكول اللحم أم لا - إذا ذكاه أحد بغير إذن مالكه عمداً أو خطأ فليس للمالك إلا أرش النقص، وهو تفاوت قيمته بين كونه حياً وكونه ميت. وليس له إلزام المذكي بأخذ الحيوان المذكى ودفع قيمته حي. نعم إذا اتفقا معاً على ذلك فلا بأس به، وكذا إذا لم يكن للمذكى قيمة، كما في جملة مما لا يؤكل لحمه.
(مسألة ٢٥٤): لابد في تعيين الارش من ملاحظة جميع ظروف الحيوان المذكى من الزمان والمكان وغيرهما بما في ذلك حال صاحبه، فإن قيمة الحيوان المذكى عند القصاب الذي يتهيأ له بيع اللحم ليست كقيمته عند المستهلك الذي لايتهيأ له بيعه.
(مسألة ٢٥٥): إذا قتل الحيوان - غير الكلب والخنزير - من دون تذكية ضمن القاتل قيمة الحيوان، إلا أن يكون فيه بعد الموت ما ينتفع به ويكون له قيمة كأنياب الفيل فيستثنى حينئذٍ من القيمة المضمونة، وكذا الحال في كل حيوان مملوك.
(مسألة ٢٥٦): من جنى على غير الكلب والخنزير بكسر أو جرح أو نحوهما كان عليه أرش العيب الحادث، وهو فرق القيمة بين واجد العيب وفاقده، ولا ضابط لذلك، بل هو يختلف باختلاف الحيوانات والاحوال، نعم من فقأ عين حيوان ذي قوائم أربع كان عليه ربع ثمنه.
(مسألة ٢٥٧): من جنى على بهيمة حامل فأسقطت حملها كان عليه لصاحبه عشر قيمته.
(مسألة ٢٥٨): لاضمان في الجناية على الخنزير، إلا أن يكون لذمي ملتزم بشروط الذمة، فعلى الجاني قيمته إذا تلف وأرشه إذا تعيّب.
(مسألة ٢٥٩): دية كلب الصيد المعلّم أربعون درهم.
(مسألة ٢٦٠): من قتل كلب الحراسة للغنم والبستان المحوط بحائط لزمه قيمته، والأحوط وجوباً ذلك في كلب الزرع غير المحوط، بل في مطلق كلب الحراسة، وأما بقية الكلاب فلا دية له.
الفصل السادس
في العاقلة
وهي التي تتحمل عن الجاني دية الخطأ المحض، كما تقدم. والعقل هو تحمل الدية.
(مسألة ٢٦١): عاقلة الجاني هم الرجال من عشيرته، وهم الذين يتقربون إليه بالاب، كالاخوة والاعمام وأولادهم ويدخل فيهم الاباء وإن علوا والابناء وإن نزلو، ولا يشترك معهم الجاني نفسه.
(مسألة ٢٦٢): يشترط في ضمان كل فرد من العاقلة التكليف - بالبلوغ
والعقل - من حين الجناية إلى حين الاداء.
(مسألة ٢٦٣): في سقوط العقل عن الفقير بالمعنى الشرعي إشكال والاظهر العدم، نعم لاإشكال في سقوطه عن العاجز الذي لايجد ما يدفعه ولا يقدر عليه بالتكسب ونحوه، ولايجب عليه الاستدانة، ولابيع مستثنيات الدين.
(مسألة ٢٦٤): لافرق في العقل بين من يتقرب بالابوين ومن يتقرب بالاب وحده، ولايتقدم الاول على الثاني.
(مسألة ٢٦٥): إذا لم يكن للجاني عشيرة كان عاقلته وليه المعتق له، فإن لم يكن له ولي معتق كان عاقلته ضامن الجريرة، فإن لم يكن ضامن الجريرة كان عاقلته الامام (عليه السلام) ، نظير ما تقدم في طبقات الميراث. لكن عقل الامام لجنايته مشروط بأن لا يكون له مال، فإن كان له مال كان عليه أداء الدية من ماله، ولا يجب على الامام عقله.
(مسألة ٢٦٦): إذا عجزت العاقلة عن أداء الدية كانت الدية في مال الجاني، فإن لم يكن له مال كان على الامام أداء الدية عنه.
(مسألة ٢٦٧): إنما تتحمل العاقلة دية الخطأ المحض كما تقدم، أما دية العمد وشبه العمد فهي على الجاني وفي ماله، ويستثنى من ذلك ما إذا هرب القاتل المتعمد فلو يقدر عليه ولم يكن له مال فإن الدية تؤخذ من قرابته الاقرب فالاقرب، فإن لم يكن له قرابة كانت ديته على الامام ولا يتعدى لغير ذلك كما تقدم في أول الفصل الثاني من أحكام القصاص.
(مسألة ٢٦٨): تضمن العاقلة كل جناية عن خطأ محض، سواءً كانت على النفس أم على الطرف أم كانت من سنخ الجروح والكسور ونحوه، وتؤدى الجميع في ثلاث سنين، كما تقدم في دية النفس.
(مسألة ٢٦٩): لاتضمن العاقلة الجناية إذا ثبتت بإقرار الجاني، بل تكون
في مال الجاني نفسه. نعم إذا أقرت العاقلة نفسها بصدور الجناية الخطأ من الجاني لزمها إقراره، وعليها أن تؤدي الدية. وكذا إذا ثبتت الجناية بالبينة فإنها تكون على العاقلة.
(مسألة ٢٧٠): إذا صالح الجاني المجني عليه بمال غير الدية لم تلزم العاقلة به، وكان في مال الجاني.
(مسألة ٢٧١): إنما تتحمل العاقلة دية جناية الخطأ من الجاني على غيره. أما لو جنى على نفسه خطأ فلا دية له، ولاتتحمل العاقلة شيئ.
(مسألة ٢٧٢): لاتتحمل العاقلة من دية الخطأ في الجروح ونحوها إلا جرحاً يوضح العظم فما زاد على ذلك، أما ما نقص عنه فعلى الجاني نفسه.
(مسألة ٢٧٣): لاتتحمل العاقلة دية الحيوان أو أرشه، وإن كانت الجناية عليه خط.
(مسألة ٢٧٤): تقسّط الدية على العاقلة بالسوية، من دون فرق بين الغني والفقير والقريب والبعيد. وإن مات بعضهم قبل أداء حصته وزعت حصته على الباقين، ولا يجب أداؤها من تركته.
الفصل السابع
في موجبات الضمان
والكلام هنا لايختص بالجناية على النفس والبدن، بل يعم الجناية على المال على ما أشرنا إليه في كتاب الغصب، فالكلام هنا فيما يوجب تحمل درك ما وقع وضمانه، فيستحق به القصاص بشروطه، والدية في الجناية على النفس والبدن، والضمان بالمثل أو القيمة في الجناية على المال. وأسباب الضمان ترجع
إلى أمرين المباشرة والتسبيب، فالكلام في مقامين..
المقامالأول: في المباشرة:
من استند إليه الحادث بالمباشرة يتحمل دركه وعليه ضمانه ما لم يكن من غيره تسبيب مضمن يرفع الضمان عنه، على ما يتضح في الامر الثاني.
(مسألة ٢٧٥): لابد في المباشرة الموجبة للضمان من صحة نسبة الفعل للمباشر عرف، ولا يكفي مجرد استناده إليه على نحو استناده للالة، فمن ألقى حجراً من شاهق على شيء فكسره كان مباشراً للكسر وعليه ضمانه، أما إذا ألقاه من شاهق ولم يكن ذلك الشيء تحته إلا أن شخصاً وضع ذلك الشيء تحت الحجر بعد إلقائه فأصابه الحجر فالمباشر عرفاً هو الثاني الذي وضع الشيء تحت الحجر، لا الاول الذي رمى بالحجر. وكذلك سائق السيارة فإنه إذا أصاب إنساناً أو حيواناً فقتله لايكون مباشراً للقتل إلا إذا كانت إصابته له مستنده لسيره، أما إذا استندت لقفزان الشخص أو الحيوان أو دفع شخص آخر لهما أمامه بحيث لا يقدر على تجنب إصابتهما لفقده السيطرة بسبب اندفاعه في السرعة فلايكون مباشراً للقتل، بل يستند القتل إليهم، أو إلى من دفعهم.
(مسألة ٢٧٦): يضمن الطبيب والبيطري والممرض وإن لم يكونوا مباشرين للعلاج، على تفصيل تقدم في كتاب الاجارة.
(مسألة ٢٧٧): إذا انقلب النائم أو تحرك فأتلف شيئاً ضمن، وإن جنى على نفس إنسان أو بدنه كانت جنايته خطأ محضاً فتحمله عاقلته.
(مسألة ٢٧٨): إذا قتلت الظئر - وهي المرضعة لولد غيرها - الولد بحركتها أو انقلابها عليه حال نومه، فإن كانت قد أخذت الولد طلباً للعز والفخر كانت جنايتها عليه في ماله، وإن كانت قد أخذته لفقرها أو لحاجته إليها أو غير ذلك كانت جنايتها على عاقلته. ويجري التفصيل المذكور في الجناية على
الولد بغير القتل من جرح أو كسر أو غيرهم.
(مسألة ٢٧٩): إذا اصطدم شخصان فاُصيب أحدهما أو كلاهم، فإن علم باستناد الاصابة لاحدهما لسرعة سيره تحمل ما يجنيه على غيره. وإن علم باستنادها لهما معاً أو احتمل ذلك ذهب نصف الجناية هدراً وثبت نصفها على الطرف المجني عليه أو على عاقلته، فإن كانت الجناية على أحدهما فقط كان على الآخر أو على عاقلته نصف ديته، وإن كانت عليهما معاً كان على كل منهما أو على عاقلته نصف الجناية التي وقعت على الآخر.
نعم إذا اصطدم الفارسان فمات أحدهما ولم يعلم باستناد الجناية لاحدهما فقط كان على الحي أو عاقلته دية الميت تامة.
(مسألة ٢٨٠): إذا اصطدمت سيارتان أو سفينتان أو غيرهم، فإذا اُصيب أحد السائقين أو كلاهما جرى ما تقدم من التفصيل بين العلم باستناد الاصابة لاحدهما وعدمه. وأما إذا اُصيب غير السائقين من الركاب فلا يذهب شيء من الجناية هدر، بل إن علم باستناد الاصابة لاحد السائقين فقط تحمل هو أو عاقلته تمام دية الجناية الحاصلة، وإلا كانت الجناية على السائقين أو عاقلتهما بالسوية. ونظير ذلك دية الجنين لو كان الاصطدام بين امرأتين كلاهما أو إحداهما حامل.
(مسألة ٢٨١): من أفزع إنساناً بصيحة أو غيرها فمات أو جن أو أصابه عيب آخر كان الضمان على الصائح أو عاقلته، وكذا إذ تحرك حركة غير اختيارية بسبب فزعه فسقط من شاهق أو نحوه فمات أو كسر أو نحو ذلك، ونظيره أيضاً ما إذا كان ذلك سبباً لنفور الدابة فسقط راكبها فمات أو كسر، أو سقط مال تحمله فتلف.
(مسألة ٢٨٢): من أخاف شخصاً ففرّ منه أو تحرك حركة اختيارية بسبب
خوفه فأصابه عطب أو كسر أو غيرهما ففي ضمان المخيف إشكال.
(مسألة ٢٨٣): إذا سقط شخص من دون اختياره على آخر فمات أو كسر أو جرح أو غير ذلك فلا شيء على الشخص الذي سقط.
(مسألة ٢٨٤): إذا دفع شخصاً على مال فأتلفه كان الضمان على الدافع وليس على المدفوع شيء، وكذا إذا دفعه على إنسان فجرحه أو كسره. أما إذا دفعه على إنسان فقتله كانت دية المقتول على المدفوع، ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه. ولو أصاب المدفوعَ شيء كان على الدافع.
(مسألة ٢٨٥): من دعا غيره ليلاً فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع إلى منزله، فيجب عليه ديته إذاجهل أمره، أو علم بموته، وإن لم يعلم أنه هو الذي قتله. نعم إذا عُلم بموته حتف أنفه من دون دخل لآخراجه من منزله فلا شيء عليه. كما أنه لو عُلم بقتل غيره له كان لاوليائه الرجوع على كل من المخرج والقاتل، فإن رجعوا على المخرج رجع على القاتل بما دفع، وإن رجعوا على القاتل لم يرجع على المخرج بشيء.
(مسألة ٢٨٦): إذا دفع أهلُ الصبي الصبيَّ لامرأة لترضعه فدفعته لغيرها على أن ترضعه من دون إذنهم ففُقد الطفل أو مات كان لهم الرجوع على التي دفعوه له، فتجب عليها ديته في ماله. إلا أن يعلم بموته حتف أنفه من دون دخل لدفعه للاُخرى، كما أنه لو علم بقتل الطفل من شخص آخر كان لاوليائه الرجوع على القاتل وعلى التي دفعوه له، على نحو ما تقدم في المسألة السابقة. والظاهر جريان ذلك فيما لو أصاب الطفلَ كسرٌ أو جرح أو غيرهما من الاُمور المضمونة.
تـتميم:
يسقط الضمان عن المباشر في موارد..
الأول: ما إذا كان المجني عليه معتدياً على الجاني وكان الجاني مدافعاً له عن اعتدائه، فإن المعتدي مهدور الدم والمال ولا سبيل على المدافع، ويلحق بذلك من اطلع على قوم في منزلهم ليشرف عليهم وينظر إلى عوراتهم، فإن لهم أن يردعوه ويرموه فإن أصابوا عينه أو جرحوه أو قتلوه فلا دية له وكانت الجناية عليه هدر.
الثاني: ما إذا كان المجني عليه معتدياً على طريق المسلمين، كالنائم في الطريق والواضع متاعه فيه بنحو يزاحم المارة، فإنه إذا أصابه المار وجنى عليه أو على ماله من دون علم كانت جنايته هدراً ولم يكن عليه ضمان.
الثالث: ما إذا رمى في موضع قد يـمر فيه إنسان وحذّر، فـمر إنسان فأصابه وهو لايعلم، فإنه لادية له، بخلاف ما إذا لم يحذّر، فإنه إن أصابه كان له الدية على عاقلة الرامي. وكذا إذا خاطر المجني عليه بنفسه، فـمرّ في المكان المعرض للجناية مع علمه بالحال فأصابه الجاني من دون عمد. والأحوط وجوباً قصور ذلك عما إذا كان الجاني معتدياً في اختيار المكان الذي يرمي فيه، كما لو رمى في ملك المجني عليه من دون إذنه أو في طريق المسلمين.
الرابع: ما إذا كان المجني عليه أو وليه قد أذن في الجناية فيما إذا كان له السلطنة على ذلك، كما في الجنايات الخفيفة غير الخطيرة، أو الخطيرة التي لها مبرر، كما في موارد دفع الافسد بالفاسد عند العلاج، دون القتل أو تعطيل العضو الذي يتعرض معه الانسان للخطر من دون مبرر، بل مطلق تعطيل العضو من دون مبرر وإن لم يتعرض معه للخطر على الأحوط وجوب. وربم
كان هناك موارد اُخرى قد تظهر عند الكلام في المقام الثاني.
المقامالثاني: في التسبيب.
(مسألة ٢٨٧): لو فعل بشخص ما يعرضه للضرر ويعجز معه من التخلص منه فحصل الضرر عليه ضمن، كما لو كتفه أو حبسه فافترسه السبع أو جرفه السيل أو نحو ذلك. وكذا لو ألقاه في أرض مسبعة فافترسه السبع من دون أن يقدر على التخلص منه. نعم لو كان الضرر بمباشرة شخص آخر مختار كان المباشر هو الضامن، كما إذا حبسه وذهب فجاء شخص آخر فقتله. كما أنه لو لم يكن لما فعله به أثر في حصول الضرر عليه فلا دية له، كما لو مات حتف أنفه.
(مسألة ٢٨٨): لو أغرى شخص حيواناً - كالكلب والاسد - بإنسان فجنى عليه كانت الجناية والضمان على المغري، وكذا إذا أغرى به صبياً غير مميز أو مجنون. أما إذا أغرى به صبياً مميزاً أو كبيراً عاقلاً فالجناية على المباشر أو على عاقلته، إلا أن يكون الاغراء بطريق الامر وكان المأمور عبداً للامر، كما تقدم في فصل قصاص النفس، نعم قد يستحق المغري التعزير، كما تقدم هناك أن الامر يخلد في السجن عقوبة وحدّ، فراجع.
(مسألة ٢٨٩): إذا كان المجني عليه في المسألتين السابقتين قادراً على التخلص من الجناية فتسامح ولم يفعل لم تكن الجناية مضمونة على الحابس والمغري.فيجب عليه ديته إذا جهل أمره أو علم بموته وإن لم يعلم أنه هو الذي قتله.
(مسألة ٢٩٠): من أضر بالطريق كان ضامناً لما يحدث بسببه من قتل أو جرح أو تلف مال، كما لو حفر فيه حفيرة فسقط فيها رجل أو حيوان، أو طرح حجر، أو أثبت وتداً فعثر به المار، أو دق مسماراً في حائط في الطريق فجرح به المار أو شق ثوبه، أو نحو ذلك. وكذا لو ألقى قشراً في الطريق فزلق به المار فضره أو ضر ماله.
(مسألة ٢٩١): من نصب ميزاباً أو غيره على الطريق بنحو لايضر بالمارة لعلوه وأحكمه، ثم وقع بزوبعة أو نحوها فأضر بنفس أو بدن أو مال فلا ضمان عليه.
(مسألة ٢٩٢): من حفر في ملك غيره، أو وضع فيه شيئ، أو بنى بناء بغير إذن المالك فهو ضامن لما يحدث بسببه على المالك، وعلى من يدخل فيه بإذن المالك. وأما ضمانه لما يصيب الداخل بغير إذن المالك عدواناً ففيه إشكال، والاظهر العدم.
(مسألة ٢٩٣): لافرق في الضمان في المسألتين السابقتين بين أن يكون إحداث ما أحدث في الطريق أو في ملك الغير لمصلحة الطريق أو لمصلحة ذلك الغير وأن لايكون كذلك. نعم لو أحدث ولي المالك في الملك شيئاً بغير إذنه لم يكن ضامناً لما يحدث على المالك بسببه إذا لم يكن مفرطاً في حقه عرف.
(مسألة ٢٩٤): لابد في الضمان فيما سبق من عدم تعمد المضرور المرور بالمكان مع الالتفات لما حدث فيه، فإن تعمد المرور بالمكان ملتفتاً لما حدث فيه لتخيل تمكنه من تجنب الضرر فوقع في الضرر فالظاهر عدم الضمان على من أحدث فيه ماأحدث، وأظهر من ذلك ما إذا أقدم على الضرر وتعمد إيقاعه بنفسه أو ماله. بل لو كان يحمل نفساً اُخرى أو مالاً لشخص آخر فتعمد العبور بالمكان لتخيل تجنب الضرر أو إقداماً على الضرر كان هو الضامن للضرر على تلك النفس أو ذلك المال، دون من أحدث بالمكان ما أحدث.
(مسألة ٢٩٥): من حفر شيئاً في ملكه أو وضع شيئاً فيه فهو لايضمن ما يحدث بسببه لمن يدخل فيه بغير إذنه، بل حتى لمن دخل فيه بإذنه، إلا أن يكون مخدوعاً ومغروراً من قبله.
(مسألة ٢٩٦): من بنى جداراً في ملكه أو في مكان مباح أو مأذون له فيه لم يضمن ما يحصل بسبب سقوط الجدار. نعم إذا سقط الجدار على الطريق أو على ملك إنسان غيره فأصاب المارة أو صاحب الملك ومن يتعلق به وكان ذلك
بتقصير من باني الجدار لميلان الجدار أو عدم إحكامه كان الباني ضامناً لما حصل. ولو كان ذلك منه غفلة من دون تقصير ففي الضمان إشكال. وهل الضامن هو المباشر للبناء أو صاحب الجدار الباذل لبنائه والامر به؟ الظاهر الاول.
(مسألة ٢٩٧): لو بنى الحائط محكماً ثم طرأ عليه الخلل وصار في معرض السقوط كان لمن يتعرض للضرر - كالجار أو المارة - إصلاحه أو تهديمه بعد استئذان المالك ووجب على المالك الرضا بذلك، وإن امتنع لزم مراجعة الحاكم الشرعي. ولو منع المالك أو غيره من تهديمه بحيث تعذر ذلك فسقط، فهل يكون المانع ضامناً لما يحدث بذلك من تلف في النفوس أو الاموال؟ إشكال. بل لاإشكال في عدم الضمان لو لم يكن المانع مقصراً لاعتقاده إحكام الحائط ولم يتدخل الحاكم الشرعي. وكذا إذا لم يلتفت أحد لحصول الخلل في الحائط ولم يطالب بإصلاحه أو تهديمه حتى سقط.
(مسألة ٢٩٨): من وضع شيئاً على مرتفع وكان معرضاً للسقوط فسقط وتلف، أو أصاب شيئاً فأتلفه كان ضامناً لما حصل. وإن لم يكن معرضاً للسقوط فسقط بشيء غير متوقع من ريح أو نحوها فلاضمان عليه.
(مسألة ٢٩٩): لو أراد إصلاح سفينة في الماء فغرقت بفعله ضمن ما حصل من جناية على النفس أو البدن مع عجز المجني عليه عن التخلص، أما ما اُصيب فيها من مال فهو يضمنه حتى لو قدر صاحبه على تخليصه فلم يفعل. نعم لو كان مأذوناً من قبل المجني عليه أو على ماله في الاصلاح ولم يتجاوز ما اُذن له فيه وتبرأ من ضمانه عليه فلا ضمان عليه، كما لو وقعت السفينة في خطر وطلبوا منه إصلاحها أملاً بالنجاة فخاف من تفاقم الخطر فتبرأ من الضمان فقبلوا منه ففعل ما هو الاقرب بنظره لدفع الخطر فأخط، كما أنه لو اُذن له في أمر خاص - كدق مسمار - ففعله غافلاً عن ترتّب الضرر وحصل الضرر فلا ضمان وإن لم يتبرأ من الضمان.
(مسألة ٣٠٠): من أجّج ناراً في ملكه فإن كانت في معرض السراية لغيره فسرت وأتلفت كان ضامناً لتلفه، وإن لم تكن في معرض السراية فسرت اتفاقاً لطارئ غير متوقع فلا شيء عليه. أما لو فعل ذلك في ملك غيره من دون إذنه كان ضامناً لما يحدث بسببها مطلق.
(مسألة ٣٠١): يجب على مالك الحيوان الصائل - كالبعير المغتلم والكلب العقور ونحوهما - منعه والاستيثاق منه، فإن فرّط في ذلك كان ضامناً لما يصيبه الحيوان من نفس أو بدن أو مال. وإن لم يكن مفرطاً في ذلك فلا ضمان عليه، كما لو لم يعلم بحاله، أو استوثق منه ومنعه فأفلت، نعم لايجري ذلك في مثل الهرّة مما هو صائل بطبعه ويتعارف التحفظ منه بسبب توقع الابتلاء به فإن صاحبه لا يضمن ما يفسده، بل على الناس التحفظ منه. إلا أن يخرج في وضعه عن المتعارف ويكون لجني صاحبه له أثر في إفساده وابتلاء الناس به، بحيث لولا ذلك لم يألف البيوت أو لم يفسد ولا يؤذي الناس ففي عدم ضمان صاحبه حينئذٍٍ لما يفسده إشكال.
(مسألة ٣٠٢): إذا تعارف منع الحيوان في وقت دون وقت، فما أصابه ذلك الحيوان في الوقت الذي يتعارف منعه فيه مضمون على صاحبه، وما أصابه في الوقت الذي يتعارف عدم منعه فيه غير مضمون على صاحبه، كالماشية التي يتعارف إطلاقها في النهار لترعى ومنعها في الليل.
(مسألة ٣٠٣): من دخل دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته، وإن كان دخوله بغير إذنهم فلا ضمان عليهم، أما لو عقره الكلب خارج الدار فإن كان عقره ليلاً فلا ضمان عليهم لتعارف إطلاقه للحراسة وتحفظ الناس منه، وإن كان عقره نهاراً ضمنوا لعدم تعارف التحفظ منه، فيلزمهم منعه لئلا يضر بالناس ويمنعهم من سيرهم.
(مسألة ٣٠٤): يجوز قتل الحيوان الصائل بغير إذن صاحبه دفاعاً عن النفس أو المال أو الاهل، بل قد يجب. ويجب أيضاً لدفع ضرره الواجب الدفع، كما لو خيف منه على مؤمن، لكن لو أمكن في الثاني الاستئذان من صاحبه وجب، وإلا فمن الحاكم الشرعي، ومع تعذره ليقتل بلا استئذان. أما قتله لغير ذلك - كالانتقام منه لو أفسد أو أضر - بغير إذن صاحبه فهو حرام، وحينئذٍٍ لو قتله من دون تذكية ضمن، وإن ذكاه ولو تذكية اضطرارية ضمن الارش، وهو فرق ما بين قيمة الحيوان الحي وقيمة اللحم. أما إذا كان قتله دفاعاً أو لدفع ضرره الذي تقدم في الصورتين الاُوليين فإن التفت للتذكية فذكاه فلا شيء عليه، وكذا إن ذهل عنها أو تعذرت فلم يذكه. أما إذا التفت للتذكية ولم يذكه تسامحاً فهو ضامن لقيمته وهو حي، لأنه معتد حينئذٍٍ بقتله من غير تذكية. ولا يكفيه أن يدفع قيمة اللحم المذكى.
(مسألة ٣٠٥): من ركب دابة وسار بها بحيث كان هو المسيِّر لها كان عليه ما أصابت بيديها وليس عليه ما أصابت برجليه، أما إذا كان لها قائد يقودها أو سائق يسوقها من دون أن يكون للراكب دخل في سيرها فلا شيء على الراكب حتى إذا أصابت بيديه.
(مسألة ٣٠٦): إذا ركب الدابة شخصان كان الضمان عليهما بالسوية.
(مسألة ٣٠٧): من قاد دابة كان عليه ما أصابت بيديها حال سيرها وليس عليه ما أصابت برجليه.
(مسألة ٣٠٨): من ساق دابة كان عليه ما أصابت برجليها حال سيره، وفي ضمانه لما أصابت بيديها إشكال.
(مسألة ٣٠٩): إذا وقف الراكب بدابته كان عليه ضمان ما تصيب بيديها ورجليه.
(مسألة ٣١٠): الدابَّة الواقفة من دون راكب إذا أصابت شيئاً فلا ضمان على أحد. نعم إذا وقف بها شخص في طريق المسلمين فأضرت بالمارة كان ضامناً لضرره، لما سبق من حرمة الطريق.
(مسألة ٣١١): إذا سارت الدابة بنفسها من دون سائق ولا راكب ولا قائد فأصابت شيئاً فلا ضمان على أحد إلا مع التفريط.
(مسألة ٣١٢): ما سبق في المسائل المتقدمة من ضمان من سبق مختص بما إذا لم يكن هناك من تستند إليه الجناية عرف، وإلا كان هو الضامن، كما إذا نخس يدها أو رجلها شخص آخر فضربت برجلها شيئاً فأضرت به، كما أن ما سبق من عدم ضمانهم لماتصيبه برجليها أو يديها مختص بما إذا لم يفرطو، أما مع تفريطهم فعليهم الضمان مطلق، كما إذا أدخلها شخص في مزرعة غيره من غير إذنه فأتلفت الزرع، أو أوقفها قرب المزرعة ولم يربطها فدخلت وأتلفت الزرع، ونحو ذلك.
(مسألة ٣١٣): إذا ألقت الدابة راكبها لم يضمن مالكها مايصيبه، إلا أن ينفرها هو أو غيره، فيضمن المنفّر له، لاستناد الجناية إليه.
(مسألة ٣١٤): إذا اجتمع سببان من أسباب الضمان المتقدمة أو أكثر، واستندت الجناية للجميع اشترك في الضمان فاعل الجميع، كما إذا وضع أحد حجراً في الطريق، وحفر آخر حفيرة فيه، فعثر أحد المارة بالحجر فسقط في الحفيرة فمات، فإن ديته تكون على الشخصين معاً يشتركان فيه. نعم إذا لم يكن أحدهما معتدياً فالضمان على المعتدي، كما لو وضع صاحب الحجرِ الحجرَ في ملكه وحفر الآخر في الطريق فعثر شخص بالحجر وسقط في الحفيرة فمات، فإن ديته تكون على حافر الحفيرة.
(مسألة ٣١٥): من خدع شخصاً فأصابه بسبب ذلك ضرر على النفس
أو البدن ضمن ما أصابه، كما إذا دعاه للسير في طريق فيه حفيرة يخشى منها أو حيوان كاسر وكان الداعي عالماً بذلك والمدعو غافلاً عنه فسار فيها فسقط فمات أو كسر، وكذا لو دعاه لطعام أو شراب مسموم، أو غير ذلك.
خاتمة
في الفصول العشائرية
تعارف في أوساط العشائر - خصوصاً من أهل الأرياف والبوادي - إجراء عقوبات وضمانات تحل بها المشاكل الناجمة عن تعدي بعضهم على بعض، وهي قد تبتني على اُمور..
الأول: تحكيم رؤساء العشيرة أو من يرتضونه في حل النزاع. وهذا أمر لايحل شرع، فإن الحكم في ذلك للحاكم الشرعي، وهو الفقيه العادل المأمون على الدنيا والدين، والذي لا تأخذه في الله لومة لائم. وعلى ذلك يحرم منهم الحكم حتى لو كان على طبق الحكم الشرعي، ولاينفذ في حق الآخرين، فإنه من حكم الطاغوت، وقد قال تعالى: (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد اُمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيد). نعم إذا لم يبتنِ الرجوع لهم على تحكيمهم، بل على مجرد استئمانهم على بيان الحكم الشرعي وتنفيذه جاز ذلك. ولزمهم التحفظ في أخذ الحكم بالرجوع لمن يجب تقليده من العلماء، على ما هو مذكور في محله، ووجب على الآخرين تنفيذه إذا تأكدوا من عدم خطئهم في معرفته.
كما أنه لو كان الرجوع لهم من أجل الرضا بما ينسِّبونه ويرجحونه في حل المشكلة من دون حكم منهم ولا إلزام بما ينسِّبون، حل الرجوع لهم وحل منهم التدخل في حل المشكلة. لكن لاينفذ ما ينسبونه في حق كل أحد إلا برضاه، ولا يحل لاحد أن يجبره عليه.
الثاني: البناء على أن بعض الاُمور جنايات تستدعي الضمان والعقوبة مع أنها ليست من الجنايات شرع، كتزوج الرجل المرأة من غير رضا أهلها وعشيرته، وأخذها لبيته الذي هو إما باطل شرعاً - كما إذا كانت بكراً وكان أبوها موجوداً - من دون أن يكون جناية يستحق بها الضمان والعقاب، أو صحيح يحرم المنع من إيقاعه، كما يحرم السعي لنقضه بعد إيقاعه، فالحكم بأن هذه الاُمور جنايات حكم بغير ما أنزل الله تعالى، وقد قال عز اسمه: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فاُولئك هم الفاسقون). وقال سبحانه: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فاُولئك هم الظالمون). وقال تعالى:(ومن لم يحكم بما أنزل الله فاُولئك هم الكافرون). وقال عز وجل: (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون). كما أن بعض الاُمور جرائم وآثام إلا أنها ليست من الجنايات المضمونة بالمال أو المعاقب عليها من قبل الناس، بل لا تقتضي إلا الردع نهياً عن المنكر، كالزنا والعياذ بالله، فالحكم فيها بالضمان حكم بغير ما أنزل الله أيض.
الثالث: إلزام عشيرة الجاني بجنايته وتحميلهم دركها من ضمانات أو عقوبات، ولا يشرع من ذلك إلا حمل العاقلة لدية الخطأ المحض، على ما تقدم تفصيله. والحكم بغير ذلك حكم بغير ما أنزل الله، ولا ينبغي للمؤمن انتهاك حرمة الله تعالى فيه.
الرابع: جعل عقوبات وضمانات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان على الجاني أو عشيرته، والكلام فيه كما سبق.
نعم إذا ابتنت هذه الاُمور الثلاثة على التنسيب لحل المشكلة من دون حكم وإلزام فلا بأس به، ولا ينفذ على أحد إلا أن يرضى بالقيام به بطيب نفسه، نظير ما تقدم في الامر الاول.
(مسألة ٣١٦): المال المدفوع إن لم يكن بعنوان الدية لم يشرع جعله ولا أخذه، إلا إذا كان جعله بعنوان التنسيب ودفع برضا صاحبه، كما سبق. وكذا إن كان بعنوان الدية لامر ليس هو جناية شرعية يستحق بها الدية. وإن كان بعنوان الدية لجناية لها دية شرعاً بحيث كان مستحقاً شرعاً فهو يعود للمجني عليه أو لوارثه كما تقدم، ولا يجوز لغيرهما من أفراد العشيرة أخذه، ولا أخذ شيء منه إلا برضاه، وإذا لم يدفع للمجني عليه ولا لوارثه، بل دفع لرئيس العشيرة - مثلاً - فلا تبرأ ذمة الجاني إلا بعد وصوله لهم. نعم إذا كان المجني عليه أو وارثه قد وكل رئيس العشيرة أو غيره في القبض عنه برئت ذمة الجاني بالدفع للشخص الذي وكله، وكان على ذلك الشخص إيصال المال للمجني عليه أو لوارثه أو لمن يرضى بإيصاله له.
(مسألة ٣١٧): كثيراً ما تكون الدية المدفوعة أقل من الدية الشرعية. وحينئذٍٍ لا تبرأ ذمة الجاني إلا برضا المجني عليه أو وارثه وإبرائهم. وإذا كان المجني عليه أو وارثه قاصراً لم يكن لوليه الابراء عنه، لانه مخالف لمصلحته، بل تبقى حصته بتمامها في ذمة الجاني لاتبرأ ذمته إلا من مقدار ما دفع.
(مسألة ٣١٨): إذا رضي المجني عليه أو وارثه بالدية فليس لهما بعد ذلك حق الشكاية على الجاني وطلب عقوبته حسب القوانين الوضعية. نعم ليس عليهما السعي لرفع العقوبة عنه إذا كان اعتقاله بمقتضى الحق العام تبعاً للقانون الوضعي، إلا باتفاق خاص زائد على دفع الدية.
(مسألة ٣١٩): لا يجوز الاشتراك في «المشية» التي هي مقدمة للحكم بالفصل إذا ابتنى على الخروج عن الميزان الشرعي حسبما بيّن فيما سبق. نعم إذا كان الغرض من «المشية» الشفاعة من أجل العفو أو التخفيف ممن بيده شرعاً ذلك فلا بأس بالاشتراك فيه. وكذا إذا كان الغرض منها التوسط للاصلاح
ووقف الفتنة من دون نظر لكيفية الحل، ولا إعداد له، ولا اشتراك فيه، لحث الشارع الاقدس على إصلاح ذات البين، بل قد يجب ذلك على من يستطيعه ويحسنه، كما إذا خيف من تركه تفاقم الفتنة وما يستتبع ذلك من انتشار الفساد وإراقة الدماء وانتهاك الحرمات.
ونسأله سبحانه وتعالى أن يسدد المصلحين والساعين في الخير، ويوفق المؤمنين للتمسك بدينهم، والتزام أحكامه وتعاليمه، وعدم الخروج عنها إلى تعاليم الجاهلية، ونبذ الحمية والعصبية. إنه الموفق والمعين، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
انتهى الكلام في كتاب القصاص والديات، آخر نهار السبت العشرين من شهر جمادى الثانية، الذي هو يوم ذكرى الميلاد المبارك الميمون لاُم الائمة المعصومين فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين صلوات الله تعالى عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها أجمعين، من سنة ألف وأربعمائة وسبعة عشر للهجرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة والتحية، في النجف الاشرف ببركة المشهد المشرّف على مشرفه الصلاة والسلام، وبه ختام الجزء الثالث من رسالتنا «منهاج الصالحين» المشتمل على القسم الثاني والاخير من أحكام المعاملات.
ونسأله سبحانه وتعالى العون والتوفيق والتأييد والتسديد، مع قبول السعي وصلاح النية وحسن العاقبة في جميع الاُمور وتمام العافية والسعادة في الدنيا والآخرة، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه اُنيب.
الفهرس
كتاب النكاح ٧
مقدّمة في العلاقة بين الجنسين وبين أفراد الجنس الواحد ٩
الفصل الاول: في آداب النكاح وسننه وما يناسب ذلك ١٣
الفصل الثاني: في عقد النكاح ١٩
الفصل الثالث: في أولياء العقد ٢٢
الفصل الرابع: في أسباب التحريم ٢٥
الفصل الخامس: في زواج المتعة ٣٤
الفصل السادس: في العيوب والشروط ٣٦
الفصل السابع: في المهر ٤٠
الفصل الثامن: في القسمة والنشوز ٤٥
الفصل التاسع: في أحكام الاولاد ٤٩
الفصل العاشر: في النفقات ٦٢
كتاب الطلاق ٦٩
الفصل الاول: في حقيقة الطلاق وصيغته ومالكه ٧٠
الفصل الثاني: في شروط الطلاق ٧٣
الفصل الثالث: في أحكام الطلاق ٨٠
الفصل الرابع: في العدة ٨٥
الفصل الخامس: في الخلع والمباراة ٩٥
الفصل السادس: في الظهار ١٠١
الفصل السابع: في الإيلاء ١٠٦
الفصل الثامن: في اللعان ١٠٩
كتاب اليمين والنذر والعهد ١١٥
الفصل الاول: في الحالف والناذر والمعاهد ١١٩
الفصل الثاني: فيما ينعقد به اليمين والنذر والعهد ١٢١
الفصل الثالث: في متعلق اليمين والنذر والعهد ١٢٣
كتاب الكفارات ١٣٠
الفصل الأول: في تعداد الكفارات ١٣٠
الفصل الثاني: في أحكام الكفارات ١٣٣
كتاب الإقرار ١٣٦
كتاب الغصب ١٤٣
كتاب إحياء الموات ١٥٣
كتاب اللقطة ١٦٨
الفصل الأول: في اللقيط ١٦٨
الفصل الثاني: في الضالة ١٧١
الفصل الثالث: في اللقطة ١٧٥
كتاب الصيد والذباحة ١٨٧
الباب الاول: في الصيد ١٨٧
الفصل الاول: في صيد ما له نفس سائلة ١٨٧
الفصل الثاني: في صيد ما ليس له نفس سائلة ١٩٦
الباب الثاني: في الذبح ١٩٩
الفصل الأول: فيما يقبل التذكية ١٩٩
الفصل الثاني: في الذابح ٢٠٠
الفصل الثالث: في كيفية الذبح ٢٠١
الفصل الرابع: في شروط الذبح ٢٠٤
كتاب الأطعمة والأشربة ٢٠٩
الفصل الأول: في حيوان البحر ٢٠٩
الفصل الثاني: في حيوان البر ٢١٠
الفصل الثالث: في الطير ٢١١
الفصل الرابع: فيما يحرم بالعرض ٢١٢
الفصل الخامس: في الجامد ٢١٥
الفصل السادس: في المائع ٢١٧
الفصل السابع: في بعض الاحكام العامّة ٢١٨
الفصل الثامن: في آداب المائدة ٢٢٠
كتاب الميراث ٢٢٤
الفصل الاول: في موجبات الإرث ٢٢٥
الفصل الثاني: في موانع الإرث ٢٢٦
الفصل الثالث: في ميراث المرتبة الاُولى ٢٣٠
الفصل الرابع: في ميراث المرتبة الثانية ٢٣٦
الفصل الخامس: في ميراث المرتبة الثالثة ٢٤٠
الفصل السادس: في الميراث بالولاء ٢٤٣
الفصل السابع: في ميراث الازواج ٢٤٥
الفصل الثامن: في ميراث ولد الملاعنة والزن ٢٤٩
الفصل التاسع: في ميراث الخنثى وما يشبهه ٢٥٢
الفصل العاشر: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ٢٥٥
كتاب القصاص والديات ٢٦١
الفصل الأول: في قصاص النفس ٢٦٤
الفصل الثاني: في أحكام القصاص ٢٦٩
الفصل الثالث: في قصاص الطرف ٢٧٣
الفصل الاول: في دية النفس ٢٧٩
الفصل الثاني: في ديات قطع الاعضاء ٢٨٣
الفصل الثالث: في ديات الجرح والصدع والكسر ونحوها ٢٩١
الفصل الرابع: في ديات المنافع ٣٠١
الفصل الخامس: في دية الحمل والميت والحيوان ٣٠٩
الفصل السادس: في العاقلة ٣١٢
الفصل السابع: في موجبات الضمان ٣١٤