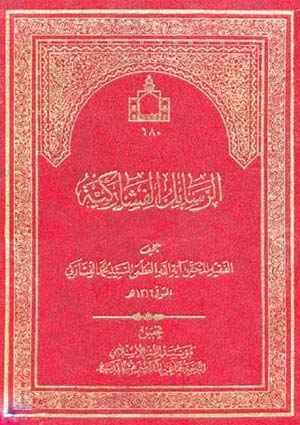الرسائل الفشاركية
الفقيه المحقق آية الله العظمى السيد محمد الفشاركي
هذا الكتاب
نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف
شبكة الإمامين الحسنينعليهماالسلام للتراث والفكر الإسلامي
بانتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشاء الله تعالى.
الرسائل الفشاركية
تأليف
الفقيه المحقق آية الله العظمى السيد محمد الفشاركي
المتوفى سنة ١٣١٦هـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه والصلاة التامة على محمّد خيرة اللّه وآله آل اللّه واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء اللّه.
من الامور التي امتازت بها حياة فقهائنا العظام - رضوان اللّه تعالى عليهم - العطاء الدائم والنفع الجاري في أثناء حياتهم وبعدها، المتمثل بما سطروه من الفوائد العلمية والتحقيقات النظرية، والتي بمجموعها شكّلت صرح الطائفة العلمي وتراثها الفكري، بحيث صارت مورداً للأجيال على مرّ العصور والدهور، لا يخيب واردها ولا يرجع قاصدها الاّ بتحقيق أمله ووجدان ضالّته.
ومن جملة تلك الحسنات الجارية لفقهائنا هذه الرسائل الستة التي بين يديك (رسالة في أصالة البراءة، رسالة في تقوّي السافل بالعالي، رسالة في الدماء الثلاثة، رسالة في أحكام الخلل في الصلاة، رسالة في الخيارات، رسالة في الاجارة) والتي سطرتها يراعة المحقق المدقّق آية اللّه السيد محمّد الطباطبائي الفشاركي، والذي كان يعدّ قطباً من أقطاب المدرسة السامرائية بعد استاذه المجدّد الشيرازي -قدسسره - ثم عاد إلى النجف الاشرف واشتغل بالتدريس والتدقيق، قال المتتبع الأقا بزرك الطهراني: « واشتغل هناك - أي في النجف الأشرف - بالتدريس في المسجد الهندي، فقد اكبّت على الاستفادة من مجيئه الأفاضل. فاجتمع في مبحثه زهاء ثلاثمائة منهم، وهم متهجين مسرورين من قدومه وتوفيق الاستفادة من انفاسه وأنواره ».
ولا يسعنا هنا الا وان نتقدم بجزيل شكرنا للعلامة المحقق سماحة الشيخ محمّد المؤمن القميّ - حفظه اللّه - من جهد حثيث في جمع نسخ هذه الرسائل وتوفيرها لنا.
وكذا نتقدّم بجزيل شكرنا لسماحة الفضيلة السيّد أبو الحسن الطباطبائي الفشاركي حفيد المصنّف ولسماحة آية اللّه الشيخ محمّد حسين الكلباسي على ما أبدوه من مساعدة لنا في توفير بعض نسخ الكتاب شكر اللّه مساعيهم وبعد جمع نسخ هذه الرسائل التي سمّيناها بـ « الرسائل الفشاركية » - قامت المؤسسة باستنساخها وتحقيقها وتخريج النصوص الشريفة وأقوال الفقهاء وتقويم متونها وطبعها ونشرها بهذه الصورة الحسنة، سائلين اللّه تعالى أن يوفّقنا للمزيد في خدمة علوم آل الرسولعليهمالسلام ، إنّه وليّ التوفيق.
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة
نبذة من حياة السيد الفشاركي أعلى اللّه مقامه
مولده:
ولد صاحب الترجمة في قرية « فشارك » من توابع أصفهان، سنة ١٢٥٣ هـ ، في اسرة كريمة النجار، عريقة في الفخار، أصلها من الشرفاء الطباطبائية القاطنين ببلدة « أزوارة ».
ومن هذه القرية هاجر جدّه الأعلى أعني الأمير شريف وأخوه الأمير مشرّف إبنا الأمير أشرف إلى « قهباية »، وهي من نواحي أصفهان، فتوطّن الأمير مشرف قرية « وير » والأمير شريف (ره) - والد صاحب الترجمة - قرية « فشارك ».
وكان عمر السيد لما توفى والده الحاج الأمير « قاسم » ست سنين.
نشأته العلمية:
سافر الى العراق وهو ابن إحدى عشر سنة، وجاور الحائر الشريف، وكفله هناك أخوه العلاّمة السيد ابراهيم المعروف بـ (الكبير)، فكمّل عنده العربية والمنطق. ثمّ اشتغل بالفقه واصوله على عدّة من علمائه؛ نظير العلاّمة الاخوند المولى محمد حسين المعروف بالفاضل الأردكاني، فاستفاد منه سنين.
وفي حدود سنة ١٢٨٦ هاجر الى النجف الأشرف وحضر بحث السيد المجدّد رئيس المذهب وطراز شرفه المذهّب آية اللّه في الزمن الحاج ميرزا محمد حسن
الشيرازي - طيب اللّه رمسه - فانقطع إليه واقتصر في الدرس عليه.
ولما هاجر السيد المجدّد من النجف الأشرف الى سامرّاء في سنة ١٢٩١ هـ حيث مرقد الامامين الهمامين أبي الحسن الهادي وأبي محمد العسكري - صلوات اللّه عليهما - صحبه السيد الفشاركي وتوطّن معه وصار من أفضل مقرّبيه وخيرة خواصّه وتلاميذه.
قال الفقيه المحقق و الاصولي المدقّق و الأريب المفلّق الشيخ أبو المجد محمد رضا الأصفهاني -قدسسره : «... فآثره - يعني المجدّد لصاحب الترجمة - على جلّ أصحابه حتّى صار عيبة سرّه المصون من العيب، وخزانة علمه المنزّه من الريب ولما كثرت أشغال العلاّمة المذكور [ المجدّد ] لتحمّله أعباء الامامة وتفرّده بالرئاسة العامّة، فوّض أمر التدريس إليه، واعتمد في تربية الأفاضل عليه، فقام بتلك الوظيفة بهمّة دونها العيّوق، وأقام للعلم بها أنفق سوق، حتى صار كعبة العلم ومطاف أصحابه، ومنتجع وفد الفضل ومراد طلابه » انتهى.
عودته الى النجف:
لمّا ثلم السلام برحيل السيّد المجدّد الى جوار ربّه الكريم في سنة ١٣١٢ هـ رجع السيد الفشاركي مهاجراً بأهله وأولاده الى الغري الشريف، والنجف إذ ذاك مجمع شيوخ الطائفة، وسدنة العلم، ومختلف ذوي الفضل والفهم، فتهافتت عليه طلاّب المعرفة روّاد العلم وبغاة الحكمة تهافت الفراش السريعة، فوردت الأفهام لديه من علوم الشريعة أعذب منهل وأصفى شريعة.
فشرع في الدرس العمومي في داره الشريفة، ثمّ وضع له منبر التدريس في القبّة التي فيها قبر استاذه المجدّد، فدرّس هناك فترة من الزمن، ثمّ انتقل بدرسه إلى الجامع الهندي.
قال الباحث الشهير الأقا بزرك الطهراني -قدسسره - في الجلد المخطوط من نقباء البشر في القرن الرابع عشر حرف الميم: « واشتغل هناك - أي في النجف الاشرف -
بالتدريس في المسجد الهندي. فقد أكبّ على الاستفادة من مجيئه الأفاضل، حتّى تبيّن الانكسار في سائر مجالس البحث التي كانت معمورة في تلك الأيّام بالفضلاء والفحول، فاجتمع في مبحثه زهاء ثلاثمائة منهم، وهم مبتهجين مسرورين من قدومه وتوفيق الاستفادة من أنفاسه وأنواره. » انتهى.
سجاياه الحميدة:
كان -رحمهالله وطيّب رمسه - قد فرّغ نفسه للعلم والعبادة وتحامى الرئاسة، ولو شاء ان يكون مرجعاً للتقليد لرميت إليه منها المقاليد، ولكنّه لفظ الدنيا لفظ النواة ورماها رمي الحجيج للحصاة، ورأى الاجتناب عنها أولى، وأن الآخرة خير له من الاولى.
قال المحدّث الخبير الشيخ عباس القمي في فوائده الرضوية نقلاً عن تكملة أمل الآمل للسيد حسن الصدر -قدسسره - : « كان المترجم له - من خواصّ أصحاب سيّدنا الاستاذ المجدد وأهل مشورته في الامور العامّة والمصالح النوعية الدينيّة الى أن توفى سيّدنا الاستاذ في شعبان سنة ١٣١٢ هـ، فجاءه جماعة من الأفاضل الذين كانوا يعتقدون أنّه الأعلم بعد السيد الاستاذ وسألوه التصدّي للامور، فقال -رحمهالله - أنا أعلم أني لست أهلاً لذلك لأنّ الرياسة الشرعيّة تحتاج الى امور غير العلم بالفقه والأحكام من السياسات ومعرفة مواقع الامور وأنا رجل وسواسي في هذه الامور، فاذا دخلت أفسدت ولم أصلح ولا يسوغ لي غير التدريس، وأشار عليهم بالرجوع الى جناب الميرزا محمّد تقي الشيرازي - دام ظلّه -. » انتهى.
وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على علوّ همّته وزكاء نفسه وتمكّن الاخلاص في قلبه ونواياه.
ومن خصاله الحميدة الاخرى: تواضعه فقد نقل عنه الشيخ أبو المجد الاصفهاني - وهو ممّن تلمّذ على يديه - ما يؤكّد هذا المعنى، فقد قال في مقدّمة وقاية الأذهان ما نصّه « فسلك - السيّد المترجم له - مسلك أجداده الأمجاد، وعاش فيها عيش
الزهّاد ما بنى فيها داراً، ولم يخلّف عقاراً، حتّى أنّه لم يكن له لما أدركناه خادم يخدمه، بل كان يذهب الى السوق بنفسه لشراء حوائجه، والطلبة حافّون به يسألونه عما اشكل عليهم من درسه، وهو واقف على باب بعض الحوانيت.
وكان مع ما منحه اللّه من الطبع الحرّ والاباء المرّ - وذلك منه شنشنة هاشمية لا أخزمية، وسجيّة علوية فاطمية - في أقصى درجات حسن الخلق والتواضع، والتعطّف على طلبة العلم، وكانوا يختلفون إليه على اختلاف طبقاتهم، واختلاف مراتبهم ومآربهم، حتّى أنّ الأصاغر منهم يقصدونه للسؤال عن بعض عبارات الكتب الابتدائية فيسمح لهم بالجواب، ويلاطفهم في الخطاب، وهو جالس في صحن داره على التراب. » انتهى.
قال السيّد محسن الأمين العاملي في أعيان الشيعة: « رأيته في النجف بعد رجوعه من سامراء ودرسه عامر وقد اخبرت انّه في ضائقة، كثير العيال، ورأيته مراراً يحمل الخبز الكثير في طرف عباءته لعياله » انتهى.
وكان -رحمهالله - ثقة ورعاً كثير الخيرات، خصوصاً فيما يتعلّق بالأئمة الأطهار -عليهمالسلام - سيّما في عزاء الحسينعليهالسلام وكان حسن المحاضرة وحلوا المعاشرة.
مشايخه:
وهم بحسب الترتيب الزمني:
١ - أخوه العالم الفاضل السيّد ابراهيم المعروف بـ (الكبير).
٢ - السيّد ابن المجاهد الطباطبائي.
٣ - الاستاذ المعروف بالفاضل الأردكاني.
٤ - السيد المجدّد الميرزا محمّد حسن الشيرازي.
تلاميذه:
وهم كثيرون الاّ أن المبرّزين منهم والذين تسنّموا سدّة المرجعية وألقت اليهم
الطائفة زمامها هم:
١ - مؤسّس الحوزة العلمية في قم المشرّفة آية اللّه العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري-قدسسره -.
٢ - آية اللّه المحقّق الشيخ محمّد حسن كبّة -قدسسره -.
٣ - الفقيه البارع الشيخ محمّد حسين الكمباني الأصفهاني - نوّر اللّه مضجعه -.
٤ - الفقيه المحقّق والاصولي المدقّق الميرزا محمد حسين النائيني - طيّب اللّه رمسه -.
٥ - الباحث الشهير والاصولي النحرير الشيخ ضياء الدين العراقي - نوّر اللّه قبره -.
٦ - العلاّمة الفقيه والاصولي الأديب الشيخ محمّد رضا النجفي الاصفهاني -رحمهالله -.
مصنّفاته:
كان -رحمهالله - وللأسف قليل التصنيف نادر التأليف، قال الشيخ أبو المجد الاصفهاني:« وكان قليل التصنيف جداً على أني سمعت منه في الدرس يقول:اني لم اباحث قطّ من غير مطالعة بل ولا من غير كتابة ».
ولم يؤثر عنه الا ما جمعناه في هذا الكتاب من رسائل:
١ - رسالة في أصالة البراءة.
٢ - رسالة تقوّي السافل بالعالي.
٣ - رسالة في الدماء الثلاثة.
٤ - رسالة في خلل الصلاة.
٥ - رسالة في الخيارات.
٦ - رسالة في الاجارة.
أولاده:
١ - العالم الفاضل السيد محمّد باقر، وكان صهر اعزّ أصدقاء والده العلاّمة الأقا
الميرزا محمد تقي الشيرازي الثاني على بنته.
٢ - العالم الفاضل السيد عباس الفشاركي.
٣ - السيد العالم الفاضل السيد علي اكبر الفشاركي.
٤ - الشاب المهذّب الصفي السيد ابو طالب الفشاركي.
كراماته:
نقل أحفاده انه لما كان السيد الفشاركي في سامراء انتشر وباء الطاعون والتايفوئيد بين أهالي المدينة بشكلٍ مرعب، وكان عدد كبير من الناس يموتون في كلّ يوم.
وفي أحد الأيام اجتمع نفر من أهل العلم والتقوى في دار السيّد ودار الحديث حول الوباء الذي عمّ المدينة وما تركه من خوف ووحشة في قلوب الناس، فالتفت السيد الفشاركي للحاضرين قائلاً: اذا أصدرت حكماً شرعياً هل يجب تنفيذه؟ فأعلن الجميع بأنّ تنفيذ الحكم واجب على الجميع عند ذلك، قال: انني أصدر فتوى وحكماً شرعياً بأن يبدأ جميع الشيعة في سامراء من اليوم حتّى عشرة أيام بقراءة زيارة عاشوراء من أجل التوسل لرفع البلاء عنهم ويهدون ثواب هذه الزيارة الى الروح الطاهرة للسيّدة نرجس خاتون والدة الامام الحجّة - عجّل اللّه تعالى فرجه - والتي قبرها في سامراء في جوار الامامين العسكريينعليهماالسلام .
فصادق الجميع على فتواه ثم أبلغوا جميع الشيعة في سامراء بذلك فالتزموا به، وفي اليوم التالي رفع الوباء تماماً عن الشيعة، ولم يصب أحد منهم بالوباء. وكانت ضحايا الوباء فقط في صفوف غير الشيعة.
وفاته:
قال ابو المجد الاصفهاني: « فظهرت في كفّه الشريفة قرحة اقرحت منّا القلوب
والأكباد، ووددنا ان نفديه منها بأرواحنا لا الأجساد ، و تولّدت منها عوارض اخرى الى ان لزم داره، واستمرّ به المرض مدّة تقرب من شهر حتى قضى نحبه ، و جاور ربّه في شهر ذي القعدة الحرام من شهور سنة ١٣١٦ هـ.
ولا تسأل عمّا جرى في جنازته من العويل والبكاء، وقد جرت عن العيون بدل الدموع الدماء ودفناه في إحدى حجرات الصحن الشريف من جهة باب السوق الكبير على يسار الداخل إليه» انتهى.
فسلام عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حياً.
مصادر الترجمة
١ - مقدّمة وقاية الأذهان للشيخ أبو المجد الاصفهاني:
٢ - أعيان الشيعة للسيد العاملي.
٣ - الفوائد الرضوية للشيخ عباس القمي.
٤ - نقباء البشر في القرن الرابع عشر للاغا بزرك الطهراني (مخطوط - حرف الميم).
٥ - معارف الرجال للشيخ حرز الدين.
٦ - الذريعة الى تصانيف الشيعة للأقا بزرك الطهراني.
عملنا في التحقيق:
كان عملنا في تحقيق هذا الكتاب بالنحو التالي:
١ - جمع النسخ المتوفّرة لرسائل السيّد المصنّف واستنساخها وضمّ بعضها الى بعض واختيار الصحيح أو الاصح منها.
٢ - تخريج النصوص الشريفة وأقوال الفقهاء وتثبيت مصادرها في الهامش، وتقويم المتن وتدقيقه.
٣ - جمع الرسائل واخضاعها لترقيم واحد وبالترتيب التالي (رسالة في أصالة البراءة، رسالة في تقوّي السافل بالعالي، رسالة في الدماء الثلاثة، رسالة في أحكام الخلل في الصلاة، رسالة في الخيارات، رسالة في الاجارة).
ونلفت نظر القرّاء الكرام هنا اننا اعتمدنا في تحقيق أصالة البراءة على نسختين تفضّل بالاولى منها سماحة آية اللّه الشيخ محمّد حسين الكلباسي وبالثانية سماحة السيد أبو الحسن الطباطبائي الفشاركي وكذلك اعتمدنا في تحقيق رسالة الخلل على نسختين حصلنا عليهما من المتقدمين وانتهجنا طريقة التلفيق بين النسختين لوجود السقط فيهما وأشرنا الى موارد الاختلاف والسقط في الهامش ورمزنا لنسخة الكلباسي في الخلل « ط ١ » ولنسخة الطباطبائي فيها « ط ٢ ».
وأمّا بقيّة الرسائل فلم نحصل على اكثر من نسخة نعم هناك في متن هذه النسخ تصحيحات واشارات الى نسخة بدل وقمنا نحن بدرج هذه الموارد في الهامش برمز (خ) أو (ظ) فلاحظ ذلك.
فائدة في أصالة البراءة
وقبل الشروع لابد من مقدّمة وهي أنّ الحكم قسمان: واقعي وظاهري.
والمراد من الأوّل: حكم الشيء من حيث هو مع قطع النظر عن علم المكلّف وجهله به، الثابت في نفس الأمر، الذي لا يرتفع بقيام امارة على خلافه، ولا يعقل إناطته باعتقاد المكلّف علماً أو ظناً، لاستلزام الدور.
ومن الثاني: حكم الفعل حال الجهل بالأوّل، سواء كان الجهل بالحكم مأخوذاً في موضوعه، بأن دلّ المثبت له على أن موضوعه الشيء بعنوان انه مجهول الحكم(١) ، أو لم يكن كذلك، بل كان الدليل المثبت له يقتضي ثبوته له مطلقاً،
____________________
(١) الدليل الدالّ على الأحكام الواقعية الثانوية، اعني بها الأحكام المجعولة حال الشكّ في الأحكام الواقعية الأولية، ويعبّر عنها أيضاً بالأحكام الظاهرية يسمّى أصلاً، والدليل الدالّ على الأحكام الواقعية علماً أو ظنّاً يسمّى دليلاً.
وشأن الثاني تقديمه على الأوّل أبداً، علميّاً كان أو ظنيّاً.
أما الأول: فواضح لكونه رافعاً لموضوع الحكم المدلول عليه بالدليل الأوّل، أعني به الشك.
وأمّا غير العلمي: فان كان ذلك منه الحكم الثانوي الثابت في مورده مأخوذاً في دليله عدم البيان، حتّى البيان الشرعي، لا مجرّد الشك كحكم البراءة، والاحتياط، والتخيير.
ان قلنا بانحصار دليلها في الدليل العقلي، كان دليل اعتبار ذلك الدليل أيضاً الوارد رافعاً لموضوع الحكم، لتحقق البيان الشرعي بوروده، وان لم يرتفع الشك به، والاّ كان الوجه في التقديم هو الحكومة، أي حكومة دليل اعتبار الدليل على الأصل لأن المستفاد من أدلّة حجّية خبر العادل تنزيل أخباره منزلة الأمارة العلميّة في الحكم، بعدم تحقّق الشك معه، فيكون حاكماً على الأصل،
لكونه كاشفاً عن الواقع وطريقاً إليه، فإنّه ايضاً ظاهري، لأنّ ثبوته منوط بعدم كشف خلافه، وان لم يؤخذ الجهل في موضوعه بمقتضى دليله، كمداليل الأدلة الاجتهادية الظنيّة.
والقسم الأوّل من الثاني يخصّ بالواقعي الثانوي، لتأخّر موضوعه عن الحكم الواقعي، وربّما يشكل: بأنّ الحكم الواقعي، والمراد منه بعث المكلّف على الفعل، وان لم يستحق العقاب عند المخالفة، لعدم العلم بالبعث - كما قلنا - لا يعقل إناطته باعتقاد المكلّف، مضافاً الى الإجماع على بقائه، حال العلم والجهل، ولا ريب أنّ الأحكام الواقعيّة ثبوتها منوطة بحسن الفعل وقبحه، لإشتمال الفعل على جهة الحسن، وجهة القبح. وقد جعل الشارع أحكاماً ظاهريّة، قد تختلف مع الواقع، وهو أيضاً كالواقعي، لا يعقل إنشاؤه وتحقّقه إلاّ عن مصلحة، فيكون فعل واحد شخصي - على تقدير مخالفة الظاهري للواقعي - مشتملاً على مصلحة مقتضية للحكم الواقعي، من دون مانع عنه، ومصلحة اخرى توجب خلافه، بدون مانع، وهو محال، ويلزم اتصاف الفعل الشخصي بصفتي الحسن والقبح، وكراهة المولى وارادته له، والكل محال. ولذا منعوا من اجتماع الأمر والنهي، بل الأمر هنا أقبح، فإنّ مورد الحكمين هناك كلّيان، إتّفق وجودهما في مورد واحد بسوء إختيار المكلّف بخلاف المقام فانّ الحكمين وان كان أحدهما لنفس الموضوع وهو الواقعي والآخر بعنوان منطبق عليه إلاّ انّهما اجتمعا في الموضوع الواحد، بفعل الشارع وعموم لطفه، لا بسوء اختيار المكلّف.
والجواب: عدم استحالة الامور المذكورة في المقام، فإنّ اجتماع جهتي الحسن والقبح في فعل واحد - بحيث يكون كلّ منهما تام الاقتضاء، ولا يمنعه عن ذلك
____________________
(١) مضافاً إلى الاجماع على عدم التفرقة في اعتبار الدليل، بين أن يكون في مورده أصل أم لا، وانّه ان كان معتبراً فهو معتبر في كلا الفرضين وإلاّ فلا. فلو اريد حينئذٍ ارتكاب التخصيص في جانب الدليل لزم طرحه من اصله بخلاف الاصل، فانّه لم ينعقد في جانبه مثل هذا الإجماع حتّى يلزم من تخصيصه الطرح كلّية فلابدّ من ارتكاب التخصيص في جانبه لأنّه أولى من الطرح. (منهرحمهالله ).
صاحبه - إنّما يمتنع إذا كانت الجهتان محقّقتين في مرتبة واحدة، والمراد من وحدتها: أن يكون كلّ من الجهتين فيه من حيث هو، بحيث لا يكون وجود احداهما في الفعل موقوفاً على تحقّق الجهة الاخرى، وتماميّتها في اقتضائها كما هو كذلك عند اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد فلا ريب أنّهما حينئذٍ متباينان من حيث الاقتضاء فإن كان فيهما ما يغلب على صاحبه رجّح جهته على صاحبه، وإلاّ صار الفعل بالنسبة اليهما متساوياً من حيث الاتّصاف بالحسن والقبح، ولا يعقل أيضاً أن يختار المكلّف جهة ويعمل ما يقتضيه من الأمر أو النهي مع قطع النظر عن الجهة الاخرى، وأمّا إذا كانت الجهتان مترتبتين بحيث لم يكونا في مرتبة واحدة، وكان وجود احداهما في الفعل موقوفاً على تحقّق صاحبتها وتماميّتهما في الاقتضاء، فلا يمتنع اجتماعهما وفعلية اقتضاء كلّ منهما، وذلك لأنّ منع كلّ جهة عن فعليّة اقتضاء الاخرى ممتنع، واذا فرض امتناع المانع، وتحقّق الاقتضاء، فلا محالة يصير الاقتضاء فعليّاً.
أمّا أنّ الجهة الثانية لا تمنع عن فعلية اقتضاء الاولى، فلاّن المفروض أنّ تحقّقها ووجودها في الفعل مشروط بتماميّة اقتضاء الجهة الاولى، فهي لا تصلح لمعارضتها في اقتضائها، اذ المانعية بعد الوجود، وهي ما لم يكن اقتضاء تلك الجهة فعلياً لا يكون محقّقة بالفعل بالفرض.
وأمّا أنّ الاولى لا تمنع عن فعلية اقتضاء الثانية، فلأنّ تلك لا تقتضي في حال اقتضائها شيئاً ينافي اقتضاءها ليمنع عن فعلية اقتضائها، لأنّ الجهة الاولى لا تقتضي في مرتبتها شيئاً، والمانعية إنّما تنشأ من التنافي في الاقتضاء.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ موضوع الحكم الواقعي هو فعل المكلّف مع قطع النظر عن الجهل بالحكم والعلم لا بمعنى ملاحظة التعميم إذ هي كملاحظة حالة العلم غير معقول. والمصلحة أو المفسدة الموجودتان في الفعل المكلّف به إنّما يقتضيان بعث المكلّف - بالكسر - المكلّف - بالفتح - على الفعل وإنشائه طلب ايجاده، أو طلب تركه.
وقد عرفت أنّ موضوع الحكم الظاهري فعل المكلّف من حيث كونه جاهلاً بالحكم الواقعي. وبعبارة اخرى فعل الجاهل بالحكم الواقعي مادام جاهلاً، والمصلحة المقتضية لإنشاء الحكم الظاهري إنّما يقتضي إنشاء الحكم في حقّ هذا الجاهل مادام كونه جاهلاً، ولا مانع من وجود هذه المصلحة ضرورة إمكان أن يحدث في الفعل مصلحة توجب بعث الجاهل بالحكم الواقعي - من حيث هو جاهل - على خلاف البعث الأوّل، لا بمعنى أن يحدث فيه تلك المصلحة مطلقاً، ويكون اقتضاؤها حال الجهل. بل بمعنى أن يكون في فعل الجاهل - من حيث هو جاهل - جهة توجب بعثه حال جهله على خلاف البعث الأوّل، بحيث لو فرض محالاً أنّ الشارع لم ينشئ الحكم الواقعي الذي اقتضى إنشاؤه المصلحة التي في ذات الفعل، لا تحدث تلك المصلحة في الفعل، لعدم تحقّق موضوعها وهو فعل الجاهل بالحكم الواقعي. ولا ريب أنّ وجود هذه المصلحة متأخّرة مرتبة عن المصلحة المتحقّقة في الفعل، واقتضاؤها إنشاء الحكم وفعلية ذلك الاقتضاء، إذ المفروض أنّ تلك المصلحة إنّما تحدث في فعل الجاهل بالحكم الواقعي - من حيث هو كذلك - فلا يمنع عن اقتضاء المصلحة الواقعية وترتّب مقتضاها عليه، والمصلحة الواقعية لا تمنع حال جهل المكلّف عن بعثه على خلاف مقتضاها، لأنّ مقتضاها - وهو البعث على الفعل - حاصل، والمكلّف حال الجهل لا يمكن أن يعمل على طبق ذلك الجعل، بل تلك المصلحة لا تقتضي في حال الجهل لبعثه على الفعل وإرادته منه فعلاً، لأنّه مانع منه عقلاً فلا يمنع عن اقتضاء المصلحة الطارئة البعث على ما ينافي البعث الأوّل.
ولا يختصّ ما ذكرنا بالأحكام الظاهرية المجعولة للجاهل بالحكم الواقعي الذي لا يتمكّن من العلم بحكم الواقعة، كما أنّ الكلام ليس في الطرق العقلية التي حكم بطريقيتها العقل حال إنسداد باب العلم بالأحكام والظنون الخاصة، فإنّها ليست من المجعولات الشرعية بل الشرع في هذه الحال يمضي حكم العقل، لكون المكلّف معذوراً فالكلام في الطرق الجعلية حال الانفتاح، مثل أن يكون في بناء الجاهل
بالحكم الواقعي على الحالة السابقة مصلحة توجب حسنه والأمر به.
والأحكام الظاهرية التي تنافي حكم العقل حال الجهل بحكم الواقعة، كالاستصحاب، وأصالة الطهارة.
ودفع الإشكال بما ذكرنا عن مثلهما واضح، ولكنّه لا يتمّ في المجعولة حال الانفتاح، لأنّ جعل الطريق حال الانفتاح وإن اشتمل على مصلحة، ولم تكن المصلحة الموجبة للحكم الواقعي منافية لانشاء خلافه حال الجهل، إلاّ أنّ في هذا الجهل جهتان:
احداهما: ايجاب العمل حال الجعل على طبق الطريق.
والثانية: ترخيص ترك الاشتغال بتحصيل حكم الفعل - من حيث هو - وترخيص ابقاء المكلّف جهله، وهذا تفويت للمصلحة الواقعية، وهو قبيح عقلاً وما سبق ذكره انّما يرفع المنافاة بين إنشاء الحكم الواقعي، وانشاء خلافه حال الجهل، ولكن لا يوجب جواز مثل هذا التفويت.
فنقول: لا مانع من أن يأمر الشارع بما يفوت الواقع وينشئ حكماً يخالفه، لما في إنشاء الحكم حال الجهل من المصلحة، إذا التزم بتدارك ما يفوت من المصالح الواقعيّة، فلا مانع من جعل الطريق الموقع في خلاف الواقع حال الانفتاح، إذا اقتضى المصلحة جعل الطريق حال الجهل، إذا التزم الشارع بتدارك ما يفوت من المصالح، بسبب ابقاء الجهل الذي رخّص فيه.
هذا كلّه في بيان إمكان اجتماع المصلحتين المتنافيتين بحسب الإقتضاء مترتّباً وعدم تمانعهما.
وأمّا اجتماع الارادة والكراهة: فإن اريد منهما إجتماع إرادة حركة المكلّف على طبق الحكم الواقعي وكراهته لذلك لارادة الحركة على طبق الحكم الظاهري المخالف له، فيمنع لزومه فيما نحن فيه، فإنّ معنى كون الحكم الواقعي شأنيّاً، هو عدم إرادة الآمر حركته على طبقه حال الجهل.
وإن اريد إرادة المبغوض، وكراهة المحبوب، أي البعث على فعل المبغوض.
والبعث على ترك المحبوب، فيمنع امتناع ذلك. بل من المعقول الواقع في الخارج البعث على ترك المحبوب لمصلحة وعلى فعل المبغوض لذلك، فإنّ الموالي كثيراً ما يأمرون العبد بترك المحبوب أو فعل المبغوض لطفاً وتسهيلاً عليه، لما عليه من صعوبة الترك أو الفعل، أو لمصلحة اخرى، واضحة على العبد، أو خفيّة عليه.
الكلام في الشبهة الحكمية التحريمية
وفيها مسائل:(١)
الاولى، فيما لا نصّ فيه: اختلف الاصوليّون والأخباريون في البراءة، والاحتياط.
احتجّ الأوّلون للأوّل بالأدلّة الأربعة.
فمن الكتاب: قوله تعالى (لا يكلف اللّه نفساً الاّ ما آتيها)(٢) .
ويشكل: بأنّ التكليف وهو حمل الغير على مشقة، ظاهر في كون المراد من الموصولة الفعل. والايتاء: وهو الاعطاء ظاهر في كون المراد منها: المال، فلابدّ إمّا من تقدير فعل يناسب المقام، وهو الاعطاء، فيصير المعنى: لا يكلّف اللّه نفساً إعطاء شيء الاّ اعطاء ما اعطاها إيّاه فيناسب لقوله تعالى ما قبل ذلك: (ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه اللّه)(٣) .
وإمّا من حمل الإيتاء على الاقدار أي: لا يكلّف اللّه نفساً فعلاً إلاّ فعلاً أقدره عليه. وهذا المعنى يشمل المعنى الأوّل وغيره، وبه فسّر في « المجمع »(٤) وعلى التقديرين لا يناسب المقام.
____________________
(١) لم يصرح المؤلف -رحمهالله - بالمسائل الاخر.
(٢) الطلاق: ٧.
(٣) نفس المصدر السابق.
(٤) مجمع البيان: ج ٩ - ١٠ ص ٣٠٩.
نعم لو حمل الموصول(١) على الحكم الواقعي، كان إيتاؤه عبارة عن الاعلام به، وكان مناسباً لما نحن فيه أن صحّ تعلّق التكليف به.
وفيه اشكال: لأنّ التكليف حمل الغير على كلفة الفعل، وايقاعه في كلفة صدوره منه، إما قهراً أو بسبب بذل اختياره بواسطة ذلك السبب منزلة القهر.
والحاصل: أنّ التكليف حمل الغير على صدور الفعل الشاقّ منه، على وجه القهر والغلبة، وربّما يستعمل في احداث سبب لاختيار الفاعل فعلاً يشقّ عليه، كالالزام المترتّب على مخالفة العقاب.
نعم يصحّ تعلّقه به على أن يكون مفعولاً مطلقاً، إلاّ أنّه أيضاً مع استلزامه الاستخدام في الضمير المحذوف العائد إليه - إن حمل على الحكم الفعلي - ، اذ لا يصح تعلّقه به، لاستلزامه تحقّق الحكم الفعلي المتوقف على الإعلام به قبل الاعلام، لا يناسب مورد الآية - إن اريد به خصوص ذلك - ، ويلزم استعماله في أكثر من معنى - إن اريد غيره أيضاً ، لأنّ تعلّق التكليف بالحكم ليس كتعلقه بالفعل ليصحّ اسناده اليهما بارادة الجامع بينهما، وهو مطلق الشيء، لأنّ تعلقه بالفعل تعلّق الفعل الى المفعول به، والمفروض أنّ تعلقه بالحكم تعلق الفعل الى المفعول المطلق.
والانصاف:(٢) أن ظاهر الآية مطابق لتفسير « مجمع البيان ». وما أشرنا اليه من أن ظاهر الايتاء: هو الاعطاء، وهو يناسب كون المراد من الموصول هو المال،
____________________
(١) بناء على جعله نائباً مناب المصدر المحذوف لا مفعولاً به كما هو لازم الوجهين المذكورين (منه).
(٢) والحاصل: أن الوجوه الثلاثة مشتركة في لزوم الاضمار أو الاستعارة، والأوّل لازم الوجه أوّل إذ لابدّ فيه من تقدير الانفاق، والثاني لازم الأخيرين إذ لابدّ فيهما من استعارة الايتاء في الاقدار والاعلام أو يدّعى فيها الاضمار أيضاً، فإن متعلّق الايتاء فيهما القدرة أو العلم ويختصّ الوجه لغرابته عن المورد وعدم ارتباطه بوجوب الانفاق من الميسور وإرادة ما هو الأعمّ منه. ومن الفعل بدعوى أن الموصول مستعمل في الجامع بين الأوّلين وايتاء كل شيء بحسبه غير معقول لازمه كون الموصول في معنى المفعول المطلق بالقياس إلى بعض أفراده والمفعول به بالقياس الى الآخر، ومع التسليم فالوجوه متساوية (منه).
يمكن منعه ايضاً، بل هو - ان تعلّق بالمال - ظاهر في الاعطاء، واذا تعلّق بالفعل، فايتاؤه إقداره، وإذا تعلّق بالمعلوم فايتاؤه اعلامه، لا على نحو الاشتراك اللفظي. بل معناه: أمر ينطبق بحسب الموارد على الامور المختلفة. وبالجملة الإتيان متعدي أتى بمعنى جاء، المعبّر عنه بالفارسي بـ « آوردن » وهو يختلف بحسب اختلاف المؤتى به من الآيات.
وقوله تعالى: (وما كنا معذّبين حتى نبعث رسولاً)(١) وجه الدلالة أنّ بعث الرسول:
إمّا كناية عن مطلق البيان، لكون الغالب بيان التكاليف ببعث الرسول كما يقال: اجلس حتى يؤذّن المؤذّن أي إلى وقت الظهر، لكون الغالب مقارنة الأذان به.
وإمّا كناية عن البيان اللفظي، ويخصّص العموم بالمستقلات، أو يلتزم بعدم العقاب فيما يستقلّ به العقل، بناءً على عدم حسن العقاب بدون اللطف بالبيان اللفظي، وان حسن اللوم والذّم، أو يلتزم بالعفو وان حسن العقاب والذم فتدل على المطلوب وزيادة من عدم تحقّق العقاب في المستقلات من دون ورود الدليل النقلي. وعلى أيّ تقدير يكون وقوع العذاب مشروطاً بالبيان، فما يحتمل الحرمة ولا نص فيه لا عقاب على ارتكابه.
وفيه : أنّ ظاهر الآية الإخبار عن عدم تعذيبه تعالى الامم السابقة قبل بعث الرسول والبيان ، لأنّ ظاهر ما كان (ما كنا - ظ) لوضعه للماضي - أنّ العذاب في الزمان الماضي كان منفيّاً إلى وقت البيان وبعث الرسول، وهذا يدلّ على أنّ العذاب الدنيوي - من الخسف وغيره - الواقع في الامم السابقة إنّما كان بعد البيان لعدم تأتي العذاب الاخروي في الزمان السابق.
ودعوى انّ كان منسلخة عن الزمان هنا نظير قوله تعالى: (وما كنت متّخذ
____________________
(١) الإسراء : ١٥.
المضلّين عضدا)(١) لا شاهد لها، ومجرّد قرب التجوّز لا يوجب المصير إليه بدون دليل يوجب العدول عن الحقيقة.
ويمكن أن يقال: إنّ دلالة أمثال هذه العبائر على الدوام ليس لانسلاخ كان عن الزمان، بل لدلالة المقام على أنّ النفي السابق إنّما كان لاشتمال الفعل على حزازة، أو لعدم كون الفعل كاملاً في الحسن وهذا يقتضي أنّ الفاعل العالم بهذه الحزازة يتركه أبداً. ومن هنا علم أنّه لو دلّت الآية على نفي التعذيب دائماً، فإنّما تدلّ على نفي العذاب الدنيوي.
والقول بأنّ العذاب الدنيوي إذا كان مرفوعاً عن الامم السابقة قبل البيان، فالاخروي مرفوع عنهم بالأولوية إذ الأصعب أولى بالرفع، ويثبت ارتفاعه عنّا، إمّا لدلالة الآية على نفي العذاب الدنيوي لما أشرنا إليه، الموجب رفع الاخروي بالأولوية، أو لما يأتي من الأخبار الكثيرة، من أنّ المسامحة في شريعة نبيّناصلىاللهعليهوآله أكثر منها في الشرائع السابقة.
مدفوع بمنع الأولويّة، كيف؟ وكثير من البلايا الدنيوية التي كانت في السابقة مرفوعة عن هذه الامة دون العذاب الاخروي.
ثمّ إنّ من الاصوليين من تمسّك بالآية على البراءة في المقام، ودفع الاستدلال بها على نفي الملازمة بين حكم شرع وحكم العقل، بأنّ نفي العذاب فعلاً لا ينافي الاستحقاق وهذا بظاهره تناقض فانّ نفي الفعليّة ان لم يلازم نفي الاستحقاق فلا يثبت بها البراءة هنا وإن لازمه، فالاستدلال بها على عدم الملازمة لا يندفع بما ذكر.
ويمكن دفعه بأنّ عدم الفعلية وإن لم يلازم عدم الاستحقاق إلاّ أنّ الأخباري لمّا كان عمدة أدلته، وهي قاعدة وجوب دفع الضرر، وأخبار التثليث(٢) إنّما يوجب الاحتياط، لأنّ إرتكاب المشتبه بالحرام ايقاع النفس في هلكة العذاب، لعدم
____________________
(١) الكهف : ٥١.
(٢) الكافي: ج ١ ص ٦٧ و ٦٨ قطعة من الحديث ١٠.
الأمن منه، كارتكاب سائر المحرّمات الواقعيّة، وكان مسلّماً للإباحة الظاهرية، على تقدير ارتفاع العقاب للحرام بالعفو، ولو كان ذلك بملاحظة أدلّة البراءة كقوله: كلّ شيء مطلق على الإباحة الظاهرية فيما لا نهي فيه عموماً وخصوصاً، لعدم وجود نهي بعد اندفاع ما دلّ على حرمة الايقاع في الهلكة، لعدم تحقّق هلكة في ارتكاب ما يحتمل الحرمة؛ كان نفي الفعلية وان لم يلازم نفي الاستحقاق في نفسه كافياً في دفع دليله.
والحاصل، أنّه لمّا كان الخصم يسلّم الإباحة الظاهرية بمقتضى أدلة البراءة، على تقدير اندفاع ما يدّعى وروده عليها من الأدلّة الدالّة على حرمة إيقاع النفس في التهلكة، لدلالة دليل على عدم وجود هلكة كالآية كانت الآية كافية في دفع حجّته لدلالتها على عدم التهلكة.
ولكن دعوى الجزم بان الخصم يسلّم ذلك على تقدير نفي الفعلية مشكلة كما يأتي في ذكر أدلّتهم، إن شاء اللّه تعالى.
ويمكن دفعه تارة بأنّه لمّا فهم المستدلّ بالآية أنّ الخصم إنّما يمنع عن ترك الاحتياط لأجل زعمه أنّ في ترك الاحتياط احتمال الوقوع في هلكة العذاب الاخروي، وانّه إذا قطع بعدم فعليّة العذاب لا يمنع عن ذلك لاستدلاله بخبر التثليث وأمثاله، الزمه بان الفعلية مقطوع العدم للآية، وان لم تكن الآية كافية في إثبات البراءة، لعدم الملازمة بين عدم الفعلية وعدم الاستحقاق، ولأجل ذلك يمنع عن الاستدلال بها للملازمة في بابها.
واخرى أنّه لمّا كان الاجماع في هذه المسألة قائماً على أنّه على تقدير عدم الفعلية لا يكون الاستحقاق أيضاً إذ لم يكن في باب الملازمة هذا الاجماع ثابتاً اثبت عدم الفعلية بالآية، واستدلّ بها على المدّعى لضميمة هذه المقدمة المسلّمة ومنع عن الاستدلال بها هناك. والفرق بين الوجهين أنّه على الأول: يكون الاستدلال جدلياً، وعلى الثاني: برهانياً.
وحاصل الوجهين: أنّه لمّا كان عدم الفعلية هنا ملازماً لعدم الاستحقاق، إمّا
بتسليم الخصم لما فهم من دليله تسليمه ذلك، وإمّا للاجماع على ذلك صحّ الاستدلال بالآية، ولمّا لم يكن في باب الملازمة ملازمة بين عدم الفعلية وعدم الاستحقاق لم يصحّ الاستدلال بها هناك. ومن الآيات قوله تعالى: (وما كان اللّه ليضلّ قوماً بعد إذ هداهم حتى يبيّن لهم ما يتقون)(١) فإنّ الاضلال هنا: هو الخذلان، لعلاقة السببية، والمعنى حينئذٍ: أنّ الخذلان من اللّه سبحانه وتعالى لا يقع على قوم بعد إذ هداهم إلى الإسلام حتّى يبيّن لهم ما يتّبعونه ويجتنبونه من الأفعال والتروك، وإذا كان الخذلان كذلك فالعذاب اولى بذلك. وفيه: أنّ الظاهر من الآية كالآية السابقة، أنّ ذلك لم يقع في الامم السابقة، والأولويّة ممنوعة على تقدير تسليم إفادتها الدوام، لأنّ الخذلان أعظم من العذاب، إذ هو عبارة عن عدم نصرة العبد وإيكال أمره إليه، الذي هو سبب للضلال الذي لا هداية بعده، وللعذاب الذي لا ينتهى أمده.
ولا ريب أنّ عدم الاضلال قبل البيان - بهذا المعنى - لا ينافي استحقاق العقاب قبله، والفعلية في الجملة التي ترفع تارة بالشفاعة، واخرى باللطف والتخفيف.
ومن الآيات قوله تعالى: (ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيى من حيّ عن بيّنة)(٢) .
وفيه: أن الاستدلال انّما يتمّ اذا كان في الآية دلالة على أنّه لا يقع الهلاكة إلاّ عن بيّنة، ولا دلالة فيها على ذلك، وانّما تدلّ على أنّ الهلاكة في هذه القضية - أي قضيّة « بدر » أنّما كان عن بيّنة، ولا تدلّ على أنّ البيان يقع في جميع الوقائع، لأجل أنّ الهلكة بدون البيان لا تقع.
ومن الآيات قوله تعالى: (قل لا أجد في ما اوحي إليّ محرّماً على طاعم يطعمه إلاّ أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً)(٣) . فإنّه تعالى أمر نبيّهصلىاللهعليهوآله أن يبطل تشريع الكفّار، بعدم وجدانه ما حرّموه في جملة ما حرّم اللّه تعالى عليه، ولولا أنّ
____________________
(١) التوبة: ١١٥.
(٢) الأنفال: ٤٢.
(٣) الأنعام: ١٤٥.
في عدم الوجدان كفاية في الحكم بالحلّية الظاهرية لما ابطل كلامهم بذلك، فالنكتة في التعبير بعدم الوجدان مع امكان أن يقول: ليس فيما اوحي اليّ محرّم، هي الاشارة الى أنّ عدم الوجدان كافٍ في عدم الحرمة.
وفيه: أن الغرض من الآية ابطال تشريع الكفار للحكم بحرمة امور، ويكفي في ابطال التشريع عدم القطع بالحرمة، لعدم وجدان ما حرّموه فيما حرّم اللّه تعالى ولا يوجب حرمة الحكم بالتحريم الواقعي وجوب الحكم بالإباحة الظاهرية وحرمة الاحتياط، ليستفاد من ذلك كفاية عدم الوجدان في الحكم بالاباحة الظاهرية، وعدم وجوب الاحتياط، والحاصل ان الآية لو كان الغرض منها إبطال الاحتياط أمكن أن يقال: إنّ إبطاله لعدم الوجدان مع امكان الابطال بالحكم، لعدم الوجود للدلالة على كفاية عدم الوجدان في عدم وجوب الاحتياط، ولكنّها في مقام دفع التشريع والتوبيخ على الحكم بالحرمة، وهو لا يستلزم المنع عن الاحتياط، مع إمكان دفع الاستدلال على تقدير كون الآية في مقام رفع الاحتياط بأنّ عدم وجدانه دليل على عدم الوجود، والنكتة في العدول لين الكلام مع الخصم، المؤكّد لرفع الخصومة ولعلّه النكتة في العدول دفع التشريع ايضاً بالحكم بعدم الحرمة.
ومن الآيات قوله تعالى: (وما لكم ألاّ تأكلوا ممّا ذكر اسم اللّه عليه وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم)(١) .
وجه الاستدلال ان التوبيخ على عدم الأكل وتركه مع عدم وجوده فيما حرّم اللّه وهذا يدلّ على كفاية عدم الوجدان في الحكم بعدم الوجود وترك الاحتياط.
وفيه مضافاً إلى ما مرّ من أنّ الغرض من النهي عن الترك بناءً على انّه لازم واقعاً هو النهي عن التشريع وهو لا يلازم النظر عن الترك للاحتياط انّ الآية تدلّ بنفسها على أنّ الكفار كانوا عالمين بعدم حرمة ما بنوا على تحريمه والاجتناب عنه فانّ الموصول يدلّ على العموم ولا ريب انّه يحصل القطع بعدم وجود محرّم غير ما فصّل إذا
____________________
(١) الأنعام: ١١٩.
كان ما فصّل جميع المحرّمات فكان المعنى ما لكم لا تأكلون ممّا ذكر اسم اللّه عليه وقد علمتم انّه غير محرّم، وحينئذٍ فلا ربط له بما نحن فيه أصلاً، والفرق بين الوجهين: أنّ الأوّل مبنيّ على دعوى العلم من الخارج، ولو من الآيات السابقة عليها أنّ الغرض دفع التشريع، وهذا الوجه مبني على دلالة نفس الآية على أنّ الغرض نفي التشريع والتوبيخ عليه لما فيها من الدلالة على علمهم بأنّه ليس يحرم ما حرّموه.
وفيه: أنّ تفصيل المحرّمات انما يلازم العلم بأنّ غيره ليس بمحرّم اذا كان المخاطبون عالمين بأنّ ما فصّل جميع المحرّمات وأمّا اذا كان في الواقع جميع المحرّمات ولم يكن المخاطبون عالمين بذلك، فلا يستلزم العلم بعدم حرمة غيرها حتى يكون النهي عن التشريع مع العلم بمخالفة الحكم للواقع الذي فصّله.
ومن السنّة أخبار منها: قولهصلىاللهعليهوآله : « رفع عن امّتي تسعة أشياء الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا عليه »(١) . وجه الدلالة أنّ حرمة ما لا دلالة على حرمته غير معلومة، فهي مرفوعة، والمراد من رفعها: إما رفع المؤاخذة، أو رفع جميع آثارها التي منها المؤاخذة.
وأورد عليه: بأنّ الظاهر أنّ المراد « ممّا لا يعلمون » ما يصدر من المكلّف من الأفعال والتروك التي هي مشتبهة عليه ولا يعلمها كشرب المائع الذي لا يعلم انه شرب خمر، لا مطلق ما لا يعلمه، حتى يشمل مثل الحرمة والوجوب المجهولين، لأنّ المراد من سائر التسعة المرفوعة هو ما يصدر من المكلّف ضرورة، فهي قرينة على أنّ المراد ممّا لا يعلمون ذلك أيضاً. فالحديث حجة على البراءة في الشبهات الموضوعية لا الحكمية.
مع أنّه على تقدير أن يكون المراد من رفع التسعة رفع المؤاخذة كما هو الظاهر يكون المراد رفع المؤاخذة على نفس تلك الامور، والحرمة الغير المعلومة لا يؤاخذ عليها، وانّما المؤاخذة على موضوعها(٢) ، وهو فعل المكلف، فالمراد من رفع ما لا يعلمون
____________________
(١) الخصال: ج ٢ ص ٤١٧ ح ٩ وفيه « رفع عن امّتي تسعة:. وما اكرهوا عليه. وما اضطرّوا اليه ».
(٢) وفي نسخة « موصوفها » بدل « موضوعها ».
رفع الأفعال المجهولة بقرينة الاخوات، وبظهور تعلّق المؤاخذة المرفوعة بنفس التسعة.
ولكن يمكن أن يقال: إنّ المراد ممّا لا يعلمون(١) الواجب والحرام. وعدم العلم بهما تارة لأجل عدم العلم بعنوان الفعل الذي يدور الحرمة والوجوب على ثبوته وعدم ثبوته، وتارة لأجل عدم العلم بنفس الوجوب والحرمة، وليس في الخبر ما يدلّ على إرادة عدم العلم من جهة خاصة، فهو باطلاقه شامل لعدم العلم في أيّ وجه كان، فشرب التتن الذي هو حرام مثلاً في الواقع، لا نعلم أنّه فعل حرام، لعدم الدليل على حرمته، وقد رفع المؤاخذة على كلّ حرام لا يعلم حرمته.
ويؤيّد ذلك: أنّ تعلّق المؤاخذة بما لا يعلمون على تقدير تحقّقه في طرف الواقع، انّما هو لأجل إتّصافه بعنوان خاص، كالوجوب أو الحرمة، لا لأجل اتّصافه بسائر العناوين فالمناسب أن يراد من الموصولة أيضاً ذلك العنوان، أو يقال: المناسب لكلمة الرفع ونسبته إلى ما لا يعلمون كون الموصول كناية عن الفعل بملاحظة عنوانه الذي يكون الفعل لأجله ثقيلاً ولا ريب أنّ ذلك ليس إلاّ كون الفعل فعلاً حراماً، وكون الترك ترك واجب.
والحاصل: أنّ نسبة الرفع إلى ما لا يعلمون إمّا أن يكون من قبيل نسبة حكم المضاف الى المضاف اليه مجازاً أو يكون باضمار لفظ المؤاخذة. وعلى كلا التقديرين يكون المناسب للمقام أن يراد من الموصولة: الحرام، والواجب(٢) لا الفعل بعنوان آخر، أو بهذا العنوان المطلق، لأنّ جهة المؤاخذة والجهة التي يكون الفعل لأجلها ثقيلاً اتصافه بالحرمة والوجوب. والمناسب في مقام نسبة الشي الى الشيء، أن يلاحظ الموضوع بعنوان يناسب المحمول، لا بعنوان آخر.
فحاصل الخبر: أنه رفع عن امّتي تسعة أشياء، منها: ما لا يعلمون من الواجبات والمحرّمات، والمورد لمّا فسّر الموصولة: بالأفعال الخارجية من غير ملاحظة الوجوب
____________________
(١) ولكن يمكن تقرير الاستدلال على وجه يندفع الايراد المذكور وهو أن المراد من لا يعلمون (نسخة).
(٢) الظاهر أن العبارة هكذا: الحرام والواجب بهذا العنوان المطلق لا الفعل بعنوان آخر.
والحرمة في عناوينها منع عن صحة الاستدلال بالنسبة إلى الشبهة الحكمية، لكن يبعّد هذا الوجه: أنّه عبّر عن التسعة المنسوب اليها الرّفع بالأشياء الظاهرة في ارادة الأفعال بعناوينها العرفيّة.
ثمّ إنّ ارادة رفع جميع الآثار في الخبر وإن كان أقرب إلى رفع الحقيقة المعلوم عدمه، ويؤيّده ما في المحاسن: عن الرجل يستحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملكه أيلزمه ذلك؟ فقالعليهالسلام : لا. قال رسول اللّهصلىاللهعليهوآله : « رفع عن امتي ما اكرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وما أخطأوا »(١) .
فإنّ الاستدلال على رفع المذكورات بالحديث الدالّ على أنّ المراد: ليس رفع خصوص المؤاخذة يقتضي أن يكون المراد منه أيضاً رفع ما يعمّ المؤاخذة إذ على تقدير كون ما استشهد به الامامعليهالسلام غير ذلك الحديث لاختلاف الترتيب في العبارة، وعدم الاعتناء باحتمال النقل بالمعنى في إحداهما يصلح إرادة الأعمّ منه أن يكون قرينة على إرادة الأعم من الآخر إلاّ أنّه يبّعده انه غير ملائم لكلمة الرفع ، فانّه سواء كان المراد به خصوص الرفع أو الأعم منه والدّفع كما يأتي ينسب إلى ما يكون في ثبوته ثقل: ولا ريب أنّ كثيراً من أفراد المذكورات ما يتحقق في الخارج، ولها آثار لا يكون ثبوتها ثقيلاً على المكلّف ولا منّة في رفع مثل هذه الآثار، فلو باع ماله عمر وخطأ من زيد، ثمّ كان صلاح كلّ من المتعاقدين مضيّ هذا العقد، لكون كل منهما محتاجاً إلى عوض ماله في غاية شدّة الحاجة فلا يصحّ أن يقال: إنّ في رفع هذه المعاملة منّة عليهما. ومثل ذلك كثير في الخارج، بل يمكن دعوى مساواته لما فيه ثقل ان لم تدّع غلبته بل يوجد في أفراد الخطأ كثيراً ما ليس أثر ثقيل نظير التحجير خطأ.
مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ المروي في « المحاسن » أيضاً لا يجب أن يكون المراد منه رفع جميع الآثار بل من الجائز أن يكون المقصود رفع المؤاخذة الأعم من المؤاخذة
____________________
(١) المحاسن: ص ٣٣٩ وفيه: « سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف. ما يملك. وضع ».
المترتبة على ذات الفعل والمترتّب عليه، بملاحظة أثره الوضعي مثلاً، ولا يقتضي ذلك رفع جميع الآثار حتّى الأثر الوضعي الذي لا يترتّب عليه حكم تكليفي.
والحاصل: أنّ من القريب أن يكون المراد رفع المؤاخذة الأعم من المؤاخذة على ذات الفعل، وما يترتّب على الفعل بواسطة أثره الوضعي من غير أن يرفع سائر آثاره، وأن يكون الأفراد التي ليس لها أثر تكليفي يترتّب عليه المؤاخذة خارجاً عن مورد الرواية.
ويدفع: بأنّ الملحوظ في نسبة الرفع هوالجنس في كلّ واحد من التسعة، ويصحّ نسبة الرفع إلى الجنس وإرادة رفع جميع آثاره، اذا كان في آثاره ما يكون ثقيلاً، ويصح أن يقال: إنّ في رفع هذا الجنس منّة على المكلّف.
نعم اذا كان الامتنان يحصل برفع بعض الآثار فيجب أن يكون في رفع الآثار التي لا منّة في رفعها على المكلف مصلحة توجب عدم لغوية رفع تلك الآثار، وذلك فيما نحن فيه يمكن أن يكون هو الاطراد، وكون الافراد على نسق واحد مثلاً وحينئذٍ فإذا سلم ظهور الحديث في رفع جميع الآثار، لا ينبغي رفع اليد عن ظهوره بملاحظة عدم كون رفع الآثار منّة على المكلّفين.
والانصاف: عدم ظهوره في رفع جميع الآثار، بل الظاهر منه رفع المؤاخذة، وحيث لم يمكن إرادة رفع المؤاخذة على نفي الجنس بلا واسطة لما في خبر « المحاسن » من الدلالة على إرادة ما فوق ذلك، نحمله على إرادة رفع المؤاخذة على الفعل ولو بواسطة بعض آثاره الوضعية، ويكون معنى رفع تلك المؤاخذة رفع ما يوجب تحققها وهو الأثر الوضعي الذي أوجب التكليف الذي يؤاخذ المكلّف على مخالفته.
ثمّ انّه ربّما يورد على من استظهر منه رفع المؤاخذة، أنّ كون الحديث في مقام الامتنان يوجب أن لا يكون المراد رفع المؤاخذة، فإنّ كثيراً من الامور التسعة ما يستقلّ العقل برفع المؤاخذة عليها، بل لا يصحّ نسبة الرفع الى المؤاخذة عليها، فإنّ ما لا يعلمون، والخطأ والنسيان، وما اضطرّوا إليه، وما لا يطيقون، ممّا يستقلّ العقل بعدم المؤاخذة عليها وقبح أخذ أحد عليه، سواء كان من هذه الامّة، أو غيرها،
فحمله على رفع المؤاخذة ينافي كلمة الرفع والاختصاص المفهوم من نسبة الرفع الى الامة، والامتنان الذي يظهر من سياق الحديث.
وفيه: أنّه يتوجّه على من فسّره برفع المؤاخذة على نفس الامور التسعة، وأمّا على ما فسّرناه فلا، إذ تحقّق المؤاخذة على عدم قبض(١) الثمن الى المشتري مثلاً في البيع الواقع خطأ، لا يستقل العقل بقبحه.
والحاصل: أنّ من الجائز أن يكون الامتنان ونسبة الرفع على ما ذكرنا، انما هو بملاحظة المؤاخذة المترتّبة على التسعة بواسطة آثارها الوضعية التي نشأ منها التكليف.
نعم يبقى أنه لا منّة في رفع المؤاخذة على ما يعلمون بنفسه بلا واسطة، وقد مرّ الجواب عنه.
وقد يجاب عن ذلك بأنّ المراد من رفع المؤاخذة على الخطأ والنسيان عدم المؤاخذة عليهما اذا كان حصولهما بسبب ترك التحفّظ، لأنّ العقاب عليهما إذا كان منشؤهما ترك التحفّظ ليس ممّا يستقلّ العقل بقبحه والمراد من رفع المؤاخذة على ما لا يعلمون عدم المؤاخذة على ذلك مع امكان الاحتياط كالشاك في حرمة شيء، ولا يستقلّ العقل برفع المؤاخذة على ما لا يعلمون اذا كان الاحتياط ممكناً، والمراد من رفع المؤاخذة على ما لا يطاق، رفع المؤاخذة على ما لا يتحمّل عادة دون ما لا يقدر عليه، كالطيران في الهواء، ولكن يشكل ذلك بأن العقل كما يستقلّ بقبح المؤاخذة على الخطأ والنسيان، وما لا يعلمون، على تقدير التحفّظ وعدم امكان الاحتياط، كذلك يستقلّ بقبح العقاب على الخطأ والنسيان، وما لا يعلمون، على تقدير عدم التحفظ والاحتياط؟ مع امكانه كيف ومعظم أدلّة القائلين بالبراءة فيما نحن فيه هي القاعدة العقليّة، وهي: قبح عقاب الغافل والجاهل.
ويدفع ذلك: بأنّ المراد من رفع المؤاخذة هنا رفعها، وبمعنى عدم التكليف بما
____________________
(١) إقباض المثمن (ظ).
يمكن أن يكلّف به، ليترتّب عليه المؤاخذة واستحقاق العقاب.
فالمراد من رفع الخطأ والنسيان: عدم ايجاب التحفّظ الموجب للمؤاخذة على تقدير ترك التحفّظ وحصول النسيان والخطأ.
والمراد من رفع ما لا يعلمون: عدم ايجاب الاحتياط الموجب للمؤاخذة، واستحقاق العقاب على تقدير مخالفة الواقع وترك الاحتياط.
ولا ريب أنّ العقل أنّما يستقل بقبح العقاب على الثلاثة اذا لم يكلّف الأمر بالتحفظ والاحتياط، وأمّا مع هذا التكليف ومخالفة المكلّف فهو مستقلّ باستحقاق العقاب.
فإن قلت: ايجاب الاحتياط على الشاك في التكليف إمّا ايجاب مقدّمي، أو إرشادي، أو نفسي.
أمّا الأوّلان فتحقّقهما منوط بتنجّز الخطاب بالواقع وفعليّته، مضافاً الى أنّ الاحتياط لا يكون ممّا يتوقف عليه الاجتناب عن الحرام الواقعي ، و انّما هو مقدّمة لتحصل العلم بالاجتناب ، فلا يمكن أن يكون رفع ما لا يعلمون(١) باعتبار عدم ايجاب الاحتياط مقدّمة أو إرشاداً.
وأمّا الثالث: فثبوته لا يوجب المؤاخذة، على مخالفة الخطاب المجهول، إذ لا يكون مزيلاً للجهل به، بل المؤاخذة المترتبة على تركه انما هو مؤاخذة على مخالفة الخطاب المتعلّق به.
والحاصل: أنّ ايجاب الاحتياط على الأوّلين مترتّب على تنجّز الخطاب بالواقع، وعلى الثالث لا يوجب تنجّز الخطاب الواقعي، فلا يصحّ أن يكون المراد رفع استحقاق العقاب على مخالفة ما لا يعلمون بملاحظة رفع التنجّز بواسطة ايجاب الاحتياط.
قلت أوّلاً: إنّ ايجاب الاحتياط نفساً، وان لم يكن موجباً لتنجّز الخطاب
____________________
(١) رفع ما يعلمون (خ).
الواقعي المجهول، الاّ أنّه إذا كان سببه حصول التحفّظ عن مخالفة الواقع يصحّ أن يقال: إنّ المؤاخذة على تركه مؤاخذة على مخالفة الواقع.
توضيح ذلك: أنّ ايجاب الاحتياط عند الشك لا يكون الغرض منه الاّ أن يحصل بسببه التحفّظ عن مخالفة الخطابات الواقعيّة الثابتة في الموارد المشكوكة التي لا يتمكّن المكلّف من العلم بها، والتمييز عن غيرها حال الشك. فمطلوبية الاحتياط نفساً نظير مطلوبية التعلّم قبل الوقت نفساً، فإنّه انّما يمكن مطلقاً لأجل مصلحة في غيره، وإذا كان منشأ الخطاب بفعل حصول فائدة في غيره وموافقة خطاب آخر، يصحّ أن يقال: إنّ المؤاخذة على مخالفة هذا الخطاب مؤاخذة على مخالفة ذلك الخطاب، وأن يقال: إنّ رفع هذا الخطاب رفع المؤاخذة عن ذلك الخطاب.
وثانياً: إنّا نمنع أنّ ايجاب الاحتياط نفساً لا يوجب تنجّز الخطاب الواقعي المجهول، ولا يكون المؤاخذة على مخالفة الاحتياط مؤاخذة على مخالفة ذلك الخطاب الواقعي. وانّه يستقلّ العقل بقبح المؤاخذة على مخالفة ذلك الخطاب المجهول لأجل كون مناط قبح الخطاب - وهو الجهل - باقياً حال ايجاب الاحتياط أيضاً.
وتفصيل ذلك: أنّ ايجاب الاحتياط نفساً نظير ايجاب العمل بالامارات - بناء على القول: بان الأمر بالعمل بها، إنّما هو لأجل الايصال إلى الواقع، لا لاشتمالها على أمر آخر، فان الطريق لما كان منها ما يطابق مضمونه الواقع، ومنها ما يخالف مضمونه الواقع، ولم يتمكّن المكلّف من تمييز الموافق للواقع عن المخالف للواقع - امر الشارع بالعمل بجميع أفراد الطريق حفظاً للعبد من الوقوع في مخالفة الواقع في موارد موافقة الطريق للواقع على تقدير مخالفته للطريق.
والحاصل: أنّه أوجب اشتمال الطريق على الأحكام الواقعية واختلاط موارد موافقته للواقع مع موارد مخالفته في نظر العبد، أن يطلب المولى منه العمل بالطريق. وهذا الطلب طلب نفسي، لكن لا على حدّ سائر النفسيّات، بحيث يكون مخالفته موجباً لاستحقاق العقاب مطلقاً بل على تقدير فوت ما هو غرض المولى من الخطاب، وهو عدم الوقوع في مخالفة الواقع فتارك العمل بالطريق انما يستحق العقاب على
مخالفة هذا الأمر من حيث إنّه مخالفة في موارد مطابقة الطريق للواقع، وأمّا في موارد مخالفته للواقع، فلا يستحق العقاب على مخالفة هذا الأمر.
نعم إن قلنا: إنّ المتجرّي على المخالفة مستحق للعقاب، قلنا بالاستحقاق هنا لأجل وجود مناطه هنا، وهو عدم المبالاة بوقوع خلاف مراد المولى والجرأة على مخالفته، ونظير الطريق جميع الأحكام الظاهرية من الاستصحاب، والاحتياط، وغيرهما، وإن كان بينهما فرق، فإن في الطريق اراءة وكشفاً للواقع، والغاء لاحتمال الخلاف تعبّداً، فكان الفاعل يفعله على انه هو الواقع، وفي الاصول جعل حكم ظاهري، والسرّ في ذلك أنّ مخالفة الأمر انّما توجب استحقاق العقاب لأجل انّه تفويت لغرض المولى، فالواجبات النفسية التي تعلّق الطلب بها، ان كان الغرض حصولها في الخارج لكونها بأنفسها مطلوبة في الواقع ومشتملة على جهة محسّنه أمر الشارع لأجلها بتلك الواجبات، يكون مخالفة أوامرها موجباً لاستحقاق العقاب مطلقاً، لأنّ مخالفتها موجبة لفوات الغرض الداعي للأمر مطلقاً، وأمّا الواجبات النفسية التي لا يفوت الغرض بسبب مخالفتها الاّ على بعض التقادير، وفي بعض الموارد يكون استحقاق العقاب عند مخالفتها منوطاً بفوت الغرض، فترك العمل بالطريق لما كان فوت الغرض به انما هو على تقدير مطابقته للواقع، كان استحقاق العقاب به منوطاً بكونه مطابقاً للواقع.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ الأمر بالعمل بالطريق كما يكون موجبا لتنجيز الخطابات الواقعية المطابقة لمضمون الطريق، كذلك الأمر بالعمل بالاستصحاب، والاحتياط يكون موجباً لتنجيز الخطابات الواقعية المطابقة للاستصحاب والاحتياط، فإذا أوجب الشارع الاحتياط في موارد الشبهة تنجّز بأمره تلك الواقعيّات المشتبهة، واذا لم يأمر بالاحتياط ولم يوجبه لم يتحقّق شرائط تنجّز الواقع والحاصل ان الجهل بالواقع كما أنّه لا يرتفع بايجاب الاحتياط، كذلك لا يرتفع بايجاب العمل بالطرق الظنية، فكما أنّها موجبة لتنجّز الواقع مع بقاء الجهل، كذلك يكون ايجاب الاحتياط موجباً لتنجّز الواقع إذ المفروض أن كيفية مطلوبية
الاحتياط لا تخالف كيفية مطلوبية العمل بالطريق، ولا يكون الطريق من خواصّه رفع الجهل بالواقع، فاذا لم يكن العقل آبياً عن العقاب على مخالفته الواقع المطابق للطريق وحكم بان جعل الطريق موجب لتنجّز الواقع، كذلك وجب ان يحكم مثله عند جعل الاحتياط، فانّ مناط عدم حكمه هنا إن كان الجهل بالواقع، فقد عرفت أنّه لا يرتفع بجعل الطريق، وإن كان جهة حكمه بالتنجّز هناك كون الغرض من الأمر حصول الواقع واشتمال الطريق على الواقع في بعض الأحيان، فقد عرفت أنّ الغرض من ايجاب الاحتياط ايضاً إدراك الواقع وهو ايضاً مطابق في بعض الاحيان، فلا مناص من أحد الأمرين: إمّا الحكم بتنجّز الواقع بجعل الاحتياط، وإمّا الحكم بعدمه مع جعل الطرق الظاهرية، لعدم وجود فارق بين المقامين يوجب اختلاف الحكم فيهما.
فإن قلت: إنّ استحقاق العقاب على المعصية انّما هو لأجل كونها بنفسها من القبائح وجهة قبحها كونها من قبيل الظلم، فإنّ من حق المولى على العبد ان يطيعه بفعل ما يأمره به، وترك ما ينهاه عنه، وهذه الجهة لا يتفاوت فيها بين أن يكون الغرض من الأمر حصول الفعل بنفسه في الخارج، أو لكون حصوله موجباً لحصول أمر آخر وحينئذٍ فاذا أمر الشارع بالاحتياط أو بالعمل بالطريق يكون مخالف الأمر مستحقاً للمؤاخذة، وأمّا عدم الالزام بالاستحقاق على تقدير مخالفة الطريق للواقع انما هو لأجل عدم تسليم كون الأمر به تكليفاً والبناء على كونه إرشاداً محضاً.
قلت: لا شك أنّ الأمر بذي المقدّمة أمر بمقدّماته، بل ادّعي بداهة اللزوم بين الأمرين عند العقل ولا ريب أنّ ترك المقدّمة ليس موجباً لاستحقاق العقاب عليه، وأنّما يوجب استحقاق العقاب على ما يلزمه من ترك ذي المقدمة والحاصل أن استحقاق العقاب على مخالفة الأمر المعلوم وعدم الاستحقاق يتبع فوت الغرض وعدمه. هذا غاية ما يقال في هذا المقام، ولكنّه بعد محلّ تأمّل.
ثم إنّه ربما يورد على من بنى على حمل الحديث على رفع جميع الآثار بأنّ ذلك يوجب كثرة الإضمار وهذا بظاهره كما ترى فإنّ إرادة رفع الآثار من رفع التسعة
يمكن أن يكون على وجه الكناية، وأن يكون بتقدير لفظ الآثار، وعلى الاوّل لا إضمار أصلاً، والاضمار على الثاني لا يكون أكثر من إضمار المؤاخذة.
نعم يمكن أن يكون المقصود من كثرة الإضمار: أنّ حمله على رفع جميع الآثار يوجب الالتزام برفع امور كثيرة، وحمله على رفع المؤاخذة لا يوجب ذلك، والقدر المتيقّن رفع المؤاخذة على التقديرين، وإرادة الزائد يحتاج إلى دليل.
وفيه: مع مخالفته لظاهر اللفظ أنّ ذلك كلام من يسلّم إجمال الحديث، والكلام هنا في تشخيص ما هو ظاهر فيه اللهم الاّ أن يدّعى أنّ الحديث بنفسه وان لم يكن ظاهراً في شيء من الأمرين، الاّ انّه بملاحظة تخصيص عمومات كثيرة على تقدير إرادة رفع جميع الآثار يكون ظاهراً في إرادة رفع المؤاخذة.
وفيه: انّ الاجمال المخصّص لا يرتفع بعموم العام إذا كان العمل بالعموم لأجل التعبّد بأصالة عدم المخصّص وإن كان لأجل ظهوره نوعاً في إرادة العموم فهو يتبع المقامات باعتبار اتّصال المخصّص وانفصاله وغير ذلك من الامور التي يوجب ظهور اللفظ في معنى احياناً.
وقد يورد أيضاً على حامل الحديث على رفع جميع الآثار بانّ ذلك يوجب كثرة التخصيص في الحديث فان آثار الخطأ والنسيان غير مرتفعة.
وفيه: أنّ الآثار التي يدلّ الحديث على رفعها هي الآثار المختصة بالفعل من حيث هو مع قطع النظر عن كونه صادراً على وجه الخطأ أو العمد، أو الاكراه والاجبار، وعن كونه معلوماً أو مجهولاً، فانّ الآثار المترتّبة على الفعل تارة يترتّب عليه بواسطة صدوره على وجه العمد وهي الآثار الشرعية التي موضوعاتها الأفعال العمديّة، كالقتل عمداً، والافطار عمداً، وتارة يترتّب عليه بواسطة صدوره على وجه الخطأ أو النسيان كالكفّارة المترتّبة على قتل الخطأ، ووجوب سجدة السهو المترتّب على صدور الفعل نسياناً، وتارة يترتّب عليه من حيث هو مع قطع النظر عن العنوانين وهي الآثار التي موضوعاتها في الأدلّة الشرعية نفس الفعل من غير تقييد بالعمد والخطأ.
والمراد من الحديث رفع قسم الأخير من الآثار، فانّه المتبادر منه، مضافاً إلى إستلزامه التناقض إن اريد من رفع آثار الخطأ الآثار الثابتة في هذه الشريعة له، وإرادة رفع الآثار الثابتة لهذه العناوين في الشرائع السابقة ايضاً بعيدة.
والحاصل: أنّ المتبادر من الحديث أنّ الآثار المترتّبة على الفعل مرفوعة في حال اتّصافه بهذه العناوين لا اثار نفس هذه العناوين، كما أنّ المراد من الآثار الآثار الشرعيّة لا الآثار العقلية والعادية، فانّها غير قابلة للرفع، وكذلك الآثار التي يترتّب على الآثار العقلية والعادية، فانها آثار لها لا للأفعال حتى يدلّ ما يدلّ على رفع آثار الفعل على كونها مرفوعة.
ثم اعلم أنّ الظاهر من الرّفع إعدام ما كان ثابتاً، وإرادة هذا المعنى من الحديث غير ممكن، فالأمر دائر بين أن يكون المراد رفع ما هو ثابت بمقتضى ظواهر الأدلّة التي يكشف هذا الحديث عن عدم كون ما يدلّ على رفعه مراداً منها، وبين أن يكون المراد عدم جعل ما يكون المقتضي لجعله موجوداً لأجل الامتنان، أو مانع آخر عن فعلية إقتضاء المقتضي، والأوّل لقربه من المعنى الحقيقي يتعيّن حمل الحديث عليه، إلاّ أنّه غير ممكن، لأنّ الاحكام المجهولة ليس لها آثار وأحكام بمقتضى ظواهر الأدلّة حتى يقال: انّ رفعها عبارة عن رفع تلك الآثار، فيجب أن يكون المراد من رفعها رفع ما يكون المقتضي لجعله موجوداً وهو هنا جعل الاحتياط حال الجهل الموجب لكون الحكم ثابتاً حال الجهل كثبوته حال العلم به.
فان قلت: إنّ من الاحكام الشرعية ما يكون ثبوتها سبباً لثبوت حكم آخر كوجوب أداء الدين الموجب لفساد العبادة والنهي عنها - بناء على مذهب من يقول: ببطلانها حين وجوب الأداء لأجل النص لا لأجل اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه - وحينئذٍ فيمكن أن يكون المرفوع تلك الاحكام التي يترتّب ثبوتها على ثبوت تلك الأحكام المجهولة.
والحاصل: أنّ من الاحكام الشرعية ما يلزمه أحكام اخر كوجوب أداء الدين الذي يلزمه شرعاً النهي عن العبادة قبل الأداء، فيمكن أن يكون المراد من رفع
الأحكام المجهولة رفع الأحكام التي يترتّب ثبوتها على ثبوت تلك الأحكام المجهولة فيكون تلك الاحكام حال الجهل بملزوماتها وانّ الملازمة بين الحكمين إنما هو حال العلم بالملزوم لا مطلقاً.
قلت: سياق الحديث يقتضي أن يكون رفع التسعة لأجل الامتنان، ولزوم حكم لحكم شرعي نادر لا يكون الاّ في قليل من الموارد، فلا ينبغي حمل رفع الاحكام المجهولة لأجل الامتنان على رفع تلك اللوازم، فانّ رفع الامتنان يقتضي أن يكون المرفوع أعظم من ذلك.
فان قلت: إنّ الاحتياط من آثار الأحكام المجهولة من حيث إنّها مجهولة اذ الاحتياط حال العلم غير معقول فلا يصحّ أن يقال: إنّ المراد من رفع الأحكام عدم ايجاب الاحتياط حال الجهل بها والشك في ثبوتها.
قلت: ليس المراد من رفع تلك الأحكام رفع الاحتياط، بل المراد رفع ما يكون إثباته متوقّفاً على جعل الاحتياط، بيان ذلك: أنّ الأحكام الثابتة لمّا كان تنجيزها وفعليّتها حال الجهل غير ممكن إلاّ بجعل الطريق وما يجري مجراها من ايجاب الاحتياط، وجب على الحاكم اذا أراد تنجيز حكمه حال الجهل أن يوجب الاحتياط عند عدم تمكّن المكلّف من تحصيل طريق إلى الحكم إمّا علماً أو علميّاً، فالمراد من رفع الأحكام المجهولة: عدم توجيهها إلى المكلّف حال الجهل بسبب ايجاب الاحتياط، كما أنّ المراد من رفع الخطأ والنسيان عدم ايجاب التحفّظ الموجب تركه صحة العقاب على مخالفة الواقع خطأ ونسياناً.
ثم انّه قد يستدلّ بهذه الصحيحة على صحّة عبادة من نسي بعض الأجزاء.
وتحقيق الكلام فيه: أنّه إن قلنا انّ المقصود من الحديث رفع المؤاخذة على التسعة، فإمّا أن نقول: إنّ ظاهر رفع التسعة رفع أحكامها الموجب للمؤاخذة واقعاً، وإمّا أن نقول: إنّه ظاهر في رفعها ظاهراً، وإمّا أن نقول: إنّه لا ظهور له في شيء من الأمرين.
فان قلنا بالأوّل وصحّ ابقاء هذا الظاهر في ما لم يقم دليل على خلافه وقلنا إنّ
رفع حكم الجزء المنسيّ واقعاً ممكن عقلاً وليس ما لا يعلمون في عدم امكان رفع حكمه واقعاً، صحّ الاستدلال بالحديث على صحّة العبادة التي نسي بعض أجزائها، فانّ رفع وجوب الجزء واقعاً يستلزم كون المأمور به ما عدا الجزء المنسيّ واقعاً والمفروض الاتيان به فالمأتيّ به حال النسيان مطابق للأمر صحيح.
وأمّا اذا قلنا: أنّ رفع التسعة ظاهر في ذلك وقلنا(١) انه بعد قيام الدليل على عدم إرادة هذا الظاهر في بعض التسعة لا يمكن إبقاؤه في ما لم يقم دليل على إرادته بالنسبة إليه، بل يجب حمل الرفع على القدر المشترك بين الرفع واقعاً وظاهراً أو قلنا بأحد الوجهين الأخيرين فلا يصحّ الاستدلال، أمّا على تقدير ارادة رفع الحكم ظاهراً فظاهر، وأمّا على تقدير إرادة رفع القدر المشترك فتعيين أحد الفردين يحتاج إلى دليل، ولا دليل يوجب تعيين إرادة رفع وجوب الجزء المنسيّ حال النسيان واقعاً حتى يوجب صحة العبادة الخالية عنها.
ولا ريب أنّ الحديث ظاهر في رفع المؤاخذة الأعمّ من رفع الحكم واقعاً وظاهراً وعلى تقدير تسليم ظهوره في رفع الحكم واقعاً لا يصحّ إبقاء هذا الظاهر مع قيام الدليل على عدم إرادته في بعض التسعة، فانّ الرفع نسب إلى التسعة بنسبة واحدة، ومعه لا يمكن المراد بالنسبة إلى بعض الرفع واقعاً وبالنسبة إلى آخر الرفع ظاهراً، بل يجب إمّا حمله على إرادة الرفع ظاهراً، أو حمله على الأعمّ من الظاهر والواقع، ومعه فتعيين أحد القسمين يطلب له دليل من الخارج وحيث لا دليل بالنسبة الى رفع وجوب الجزء يوجب تعيين أحد الاحتمالين فيه لجواز رفعه ظاهراً وجواز رفعه واقعاً - على اشكال في الأخير يأتي في محلّه - لا يمكن القول بمقتضى أحد الاحتمالين، مع أنّ هنا اشكالاً آخر يسقط الاستدلال من رأسه، وهو أنّ الحديث ظاهر في رفع المؤاخذة ولا مؤاخذة على ترك الجزء سواء كان ذلك الترك في أوّل الوقت أو آخره.
أمّا على الأوّل فانّ ترك الجزء ان ترتب عليه المؤاخذة، فانّما هو بملاحظة اتّحاده
____________________
(١) ولكن قلنا (ظ).
مع ترك المجموع الذي يترتب عليه المؤاخذة، ولا ريب أنّ ترك المجموع في أوّل الوقت لا مؤاخذة عليه، وانّما المؤاخذة على تركه في جميع الوقت.
وأمّا على الثاني فلأن ترك الجزء - من حيث هو - ليس عليه مؤاخذة، وانما المؤاخذة على ترك الكل وهو غير ترك الجزء، الاّ أنّه يشكل: بأنّ المأمور به هو المجموع وترك المجموع يتحقّق في ضمن ترك بعض أجزائه، وبعبارة اخرى: ترك المجموع قد يكون في ضمن ترك جميع الأجزاء وقد يكون في ضمن ترك بعض الاجزاء، وعلى كلا التقديرين يصدق على ترك الأجزاء أو الجزء انّه ترك الكل، كما انّه يصدق على نسيان الجزء أنّه نسيان المجموع، ولا ريب أنّ على ترك المجموع مؤاخذة فيصحّ أن يقال: إنّ مؤاخذة ترك الجزء مرفوعة.
الاّ أن يقال: إنّ ترك المجموع في آخر الوقت ايضاً لا مؤاخذة وانّما المؤاخذة على الترك في مجموع الوقت وترك الجزء في آخر الوقت ليس كالكل في مجموع الوقت حتى يترتب عليه المؤاخذة المترتبة على ترك المجموع.
وإن قلنا: إنّ المقصود من الحديث رفع جميع الآثار فقد يقال في تقرير التمسّك به لصحة العبادة التي نسي بعض أجزائها: ان وجوب الاعادة والبطلان حكمان شرعيان لترك الجزء فإنّه اذا ترك عمداً يترتب عليه كلاهما ومقتضى رفع جميع الآثار أن يكون الحكمان مرفوعين اذا ترك نسياناً.
ويرد عليه: أنّ البطلان ليس حكماً شرعياً، وانما هو مخالفة المأتيّ به للمأمور به وهذا سبب لبقاء الأمر الأوّل، فوجوب الاعادة ايضاً ليس من أحكام ترك الجزء، بل هو لبقاء الأمر الأوّل المستند إلى أمر غير شرعي، وهو مخالفة المأتي به للمأمور به.
وقد عرفت أنّ الذي يدلّ على رفعه الحديث هي الآثار الشرعية لكل من الامور التسعة لا الآثار العقلية وما لا يترتّب على الآثار العقلية من الآثار الشرعية.
وقد يوجّه التمسّك بالحديث: بأنّ البطلان ومخالفة المأتي به للمأمور به الموجب لبقاء الأمر الأوّل انّما يستندان إلى أمر شرعي، وهو كون الفعل المنسي جزءً للعبادة حال النسيان، فانّ الجزئية من الأحكام الشرعية الوضعية، وإذا دلّ حديث الرفع
على أنّ الآثار الشرعية حال النسيان مرفوعة، فيدلّ على أن الجزئية التي هي ايضاً من الآثار مرفوعة، واذا كانت هي مرفوعة، يكون البطلان الموجب لبقاء الأمر مرفوعاً لعدم سبب له، فانّ المأمور به اذا كان ما عدا الجزء المنسيّ من الأفعال، لا يكون المأتي به مع ترك ذلك الجزء مخالفاً للمأمور به.
فان قلت: رفع جزئية الفائت نسياناً مدلول الحديث، وأمّا كون المأمور به خصوص ما عدا الجزء المنسيّ من الأجزاء حال النسيان فهو لا دلالة عليه.
قلت: مبنى رفع الجزئية حال النسيان كون المأمور به ما عدا الجزء المنسيّ، إذ على تقدير عدم كونه مأموراً به فالمرفوع هو الأمر بالكل ووجوبه، لا جزئية الجزء.
والحاصل: أنّ الدالّ على رفع الجزئية دالّ على كون المأمور به ما عدا المنسي من الأجزاء.
ولكن يرد عليه: أنّ الجزئية أيضاً نظير البطلان في عدم كونه حكماً شرعياً، بل هي من الاعتبارات العقليّة اللاحقة للبعض، نظير الكلية اللاحقة للكل، فانّه إذا لوحظ امور متعدّدة بملاحظة الصورة الاجتماعية شيئاً واحداً يلحقه بملاحظة تقوّمه بامور متعدّدة اعتبار عقلي وهو وصف الكلية ويلحق كلّ واحد من الأجزاء بملاحظة كونها ممّا يتقوّم بها الكل وصف الجزئية، فهي غير قابلة للرفع كما أنّ البطلان غير قابل له.
بقي الكلام في أنّ فعل القاطع نسياناً هل هو مثل ترك الجزء في عدم دلالة الحديث على رفع حكمه؟
فنقول: يمكن أن يفرّق بينها بأن ترك الجزء ليس من أحكامه الشرعيّة بطلان الكل بدونه، وانّما يحكم بذلك العقل بعد العلم بدخوله في الكل، ولكن بطلان العمل في القواطع انما هو من احكامها الشرعية ومن الحكم استفيد مانعيتها.
والحاصل: انّ بطلان الفعل بترك الجزء انما استفيد من حكم العقل بعد العلم بدخوله في مفهوم العبادة، والبطلان في القواطع انّما علم بحكم الشارع واستفيد من ذلك الحكم المانعية، وإذا كان إبطال العمل من أحكامها الشرعية، يكون الدالّ
على رفع الأحكام الثابتة للفعل عند صدوره نسياناً دالاًّ على رفع هذا الحكم. ولما ذكرنا تمسّك العلاّمة(١) في ردّ الشافعيّ حيث أفتى بأنّ تناول المفطر سهواً موجب للقضاء بحديث الرفع، وقال: انّ الفتوى بذلك مخالف لقول النبيصلىاللهعليهوآله رفع.. الخ(٢) .
ثم اعلم: أنّ الآثار المرفوعة هي الآثار التي في رفعها إمتنان على جميع الامّة، فما لم يكن رفعها موجباً له، بل يكون منافياً له بالنسبة الى بعض، لا يكون مرفوعاً، فلا يكون مثل الاتلاف نسياناً مرفوع الحكم.
وأمّا الحلف بالعتاق، وصدقة ما يملك الذي دلّ الحديث على رفعه - إذا صدر عن اكراه - فليس من هذا القبيل، فانّ عتق العبد نفع راجع اليه وصدقته ما يملك نفع راجع إلى الفقراء فليس في رفع الالزام بهما ضرر على الغير حتى يكون مثل الاتلاف في كون رفعه منافياً للامتنان لأجل إشتماله على ضرر الغير.
وأمّا الإكراه بالاضرار فيمكن أن يقال فيه أيضاً: إنّ رفعه راجع إلى عدم ايجاب التضرّر لأجل دفع الضرر عن الغير، وذلك لأنّ غرض المكره ابتداءً يتعلّق بضرر الغير، وانما جعل ضرر المكره وعيداً ليحصل بسببه ذلك الضرر، فالمضرّ حقيقة هو المكره والمكره رافع ضرره بتضرّر نفسه، فرفع حكمه راجع إلى عدم ايجاب دفع الضرر عن الغير اذا كان ذلك موجباً للتضرّر، هذا غاية التوجيه وفيه تأمّل.
ومن الأخبار: قولهعليهالسلام : ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم(٣) .
وجه الدلالة أنّ الحكم المشكوك محجوب علمه عن الشاك فهو موضوع عنه.
ويرد عليه: أنّ الظاهر من قولهعليهالسلام ما حجب اللّه علمه هو ما لم يبيّنه للعباد وستره عنهم، وكون ذلك موضوعاً لا يقتضي أن يكون الأحكام التي بيّنها
____________________
(١) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٥٦٩.
(٢) الخصال: ج ٢ ص ٤١٧ ح ٩.
(٣) وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب صفات القاضي ح ٢٨ ج ١٨ ص ١١٩.
للعباد ببعث الحجج وبيانهم خفي ذلك بإخفاء الظالمين وكتمانهم الحق موضوعاً عن العباد، فهو دالّ على وضع ما لم يكن من قبل اللّه طريق إلى معرفته ولم يبيّنه الحجج وكانوا يخفونه عن العباد، فهو حينئذٍ نظير المروي عن اميرالمؤمنينعليهالسلام : انّ اللّه حدّ حدوداً فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تعصوها، وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً فلا تكلّفوها، رحمة من اللّه لكم(١) .
لا يقال: الوضع نظير الرفع في ظهوره في إعدام ما هو ثابت وموجود، ولا وضع فيما لا طريق إليه اصلاً، إذ هو موضوع بحكم العقل، وليس ما يقتضي ثبوته موجوداً حتى يكون نفيه وضعاً ورفعاً فهو يقتضي أن يكون المراد ممّا حجب اللّه أعم من ذلك.
لانّا نقول: مع أنّ ظهور الوضع في ذلك ليس كظهور الرفع، أنّ المراد من الوضع عدم الاثبات بجعل الطريق إليه مع كون المقتضي للاثبات موجوداً، لأجل التسهيل على العباد والرحمة بهم، كما هو المقتضى الخبر الثاني، أو مطلق عدم الاثبات بقرينة قولهعليهالسلام ما حجب اللّه علمه عن العباد، وكون هذا قرينة على التصرّف في ما حجب اللّه، ليس بأولى من كونه قرينة على التصرّف في ذلك، بل هذا أولى، لقوة ظهور قوله ما حجب اللّه فيما ذكرنا.
والحاصل: أنّ المراد من الوضع أحد المعنيين، وليس ظهوره في رفع ما يكون مقتضى الأدلّة ثبوته قابلاً للمعارضة مع ظهور قوله: ما حجب اللّه علمه فيما لا طريق اليه، بحيث يصير قرينة على إرادة خلاف ظاهره منه.
وقولهعليهالسلام : الناس في سعة ما لا يعلمون(٢) .
وجه الدلالة: أنّ « ما » إمّا موصولة اضيف إليه السعة، أو مصدرية زمانية، وعلى التقديرين يثبت المطلوب، فانّ معناه على الأوّل: أنّ الناس في سعة كلّ شيء لا يعلمونه، فيدلّ على أنّ الحكم المجهول يكون الجاهل به في سعة، وعلى الثاني
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب صفات القاضي ح ٦١ ج ١٨ ص ١٢٩ وفيه « فلا تنقصوها ».
(٢) المحاسن: ص ٤٥٢ وفيه: « ما لم يعلموا ».
معناه: أنّ الناس في السعة ما دام لا يعلمون فيدلّ على أنّ من لا يعلم الحكم الواقعي ما دام لا يعلم في السعة.
والجواب: أمّا على الوجه الثاني فواضح، فانّ دلالته على أنّ الحكم الواقعي ما دام كونه مجهولاً يكون الناس في سعة حتى يعارض الاخبار الدالّة على وجوب الاحتياط فممنوع.
ومنها: رواية عبد الأعلى عن الصادقعليهالسلام قال: سألته عمّن لم يعرف شيئاً هل عليه شيء؟ قال: لا(١) .
والاستدلال به مبني على أن يكون المراد من الشيء الجزئي الحقيقي للعين المفروض في الخارج، وأمّا اذا كان المراد منه: معنى النكرة - الموجب وقوعه في سياق، النفي حمله على العموم - فيصير الخبر ظاهراً في السؤال عن حال القاصر الذي لا يدرك شيئاً، فلا ربط له بالمقام، وظهوره في الأول ممنوع.
ومنها: قولهعليهالسلام : أيّما امرئ ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه(٢) .
والاستدلال به مبني على أن يكون المراد من الجهالة مطلقاً عدم العلم، ومن الشيء العقاب، فيكون المعنى أيّ امرئ ركب امراً من غير علم بحرمته فلا عقاب عليه.
والظاهر من الجهالة: هو الخطأ في الاعتقاد، والمراد من الشيء الكفارات المترتّبة على الافعال، لورود الخبر في باب كفارات الاحرام في قضيّة إمرأة ارتكبت بعض محرمات الاحرام جهلاً فلا ربط للخبر بما نحن فيه.
وممّا يؤيّد أن يكون المراد من الجهالة هو الخطأ في الاعتقاد أنّه لو كان المراد مطلق عدم العلم لزم تخصيص الحديث بصورة عدم كون الجاهل مقصّراً، إذ الجاهل المقصّر مؤاخذ قطعاً.
____________________
(١) الكافي: ج ١ ص ١٦٤ ح ٢.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٧٢ قطعة من الحديث ٤٧.
والظاهر ورود الاشكال على تقدير حمله على الخطأ في الاعتقاد ايضاً، إذ لو كان الخطأ بسبب تقصير في المقدّمات لا يكون المخطئ معذوراً.
ومنها: قولهعليهالسلام : ان اللّه يحتجّ على العباد بما آتاهم وعرّفهم(١) . فانّه دلّ على أنّ ما لم يكونوا قادرين عليه ولا عارفين به لا حجة فيه عليهم.
والجواب عنه كالجواب عن قولهعليهالسلام : الناس في سعة، بعينه.
ومنها: مرسلة الفقيه: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي(٢) .
وفي دلالته إشكال، وجه الدلالة: أنّ الاطلاق إمّا ظاهر في الرخصة في الفعل أو عدم المنع، وظاهر الورود هو الوصول وظاهر النهي هو النهي عن الشيء - من حيث هو - ، لا النهي عنه بعنوان أنّه مجهول الحكم، فالمعنى: أنّ كلّ فعل مرخّص فيه ولا منع عنه إلى أن يصل نهي عنه بخصوصه، فدلّ على انّه عقاب(٣) على الفعل ما لم يصل نهي إلى المكلّف عن فعله.
ويرد عليه: أنّ الورود هو النزول، وليس في الكلام ما يدلّ على أنّ المراد منه هو النزول على المكلّف، فيمكن أن يكون جعل الورود غاية الاطلاق بملاحظة جهة الصدور، وعليه مدلول الحديث إباحة الأشياء قبل ورود الشرع، ولا دلالة فيه على انه بعد صدور النهي وورود الشرع يكون الشيء مباحاً قبل وصول النهي إلى المكلّف.
والحاصل: أن الورود له جهتان: جهة الصدور، وجهة الوصول، وكونه غاية للاطلاق كما يمكن أن يكون بملاحظة جهة الوصول كذلك يمكن أن يكون بملاحظة جهة الصدور وليس في الحديث ما يدلّ على أنّه غاية باعتبار جهة الوصول، إذ ليس في قوله: « كل شيء مطلق » دلالة على ان المراد من الشيء هو المجهول الحكم حتى يقال: إنّ اباحة مجهول الحكم لا يمكن أن يكون صدور النهي غاية لها،
____________________
(١) الكافي: ج ١ ص ١٦٤ ح ٤.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٣٧.
(٣) الظاهر هنا سهو القلم والصحيح: لاعقاب.
ولا في قوله: « يرد فيه » دلالة على أنّ غايته الورود بملاحظة جهة الوصول حتى يقال: إنّ الوصول إلى غير معيّن وفعليّة التكليف بالنسبة إلى شخص مجهول لا يعقل أن يكون غاية لاباحة الفعل، فانه تعليق الحكم على غاية مجهولة، واذ ليس ما يدلّ على ذلك، فإمّا أن يكون ظاهراً في كون الورود غاية بملاحظة جهة الصدور، أو مجملاً وعلى أيّ تقدير لا دلالة فيه على المدّعى.
فان قلت: ما معنى الاباحة قبل صدور النهي؟
قلت: معناها الرخصة المالكية توضيحه: أنّ المنع عن الفعل تارة بملاحظة ما يشتمل عليه من المفسدة، وتارة بملاحظة كون الناهي مالكاً للمنهي ولتصرّفاته، ولذلك يعتبر بحكم العقل في صدور الفعل من المنهي علمه بانّ مالكه ومالك تصرّفاته راض بما يصدر من الأفعال الخارجية عنه والمنع على هذا الفعل من هذه الجهة لا يتفاوت فيه الأمر بالنسبة إلى الأفعال، سواء كانت واجبة بملاحظة ما يشتمل عليه من المصلحة، أو محرّمة لاشتماله على المفسدة، أو مباحة لعدم شيء من المصلحة والمفسدة فيه، أو كان مستحبّاً أو مكروهاً، لعدم بلوغ المفسدة والمصلحة درجة توجب الالتزام بالترك أو الفعل، إذ ليس هنا مناط هذا النهي وجود المفسدة وعدم المصلحة المزاحمة عنها حتى يختلف حالها بالنسبة إلى الأفعال.
وحاصل معنى الحديث: أنّ المالك الحقيقي للأشياء لا يمنع - من جهة كونه مالكاً - عن شيء من الأفعال، فما لم يصدر منه نهي بملاحظة ما في الفعل من المفسدة، أو صدر وعلمه الوسائط ولم يصدر منهم نهي لاقتضاء الحكمة تأخير التبليغ، لا يكون المكلّف من جهة كونه مملوكاً ممنوعاً من التصرّف بل هو مأذون في أفعاله.
ويحتمل أن يكون المراد من الاباحة هي الاباحة الظاهرية اذا كان المراد من عدم صدور النهي عدم صدوره عن النبيصلىاللهعليهوآله والائمّةعليهمالسلام ، وعليه ايضاً أنّ الأفعال التي لم يصدر منهمعليهمالسلام نهي عنها امّا لعدم كونه في الواقع منهياً عنه، أو لعدم اقتضاء المصلحة بيان النهي وتبليغه، واحتمل عند المكلّف أن يكون منهياً عنه في الواقع هي مباحة ظاهراً إلى أن يصدر نهي وعليه أيضاً لا يدلّ
على أن الافعال التي صدر النهي عنها ولم يبلغ إلى المكلّف بواسطة إخفاء الظالمين يكون ذلك مباحاً ظاهراً.
نعم يمكن إثبات الاباحة الظاهرية بعد الشك في كون الفعل منهيّاً عنه في الواقع صدر عنه، عنهم(١) عليهمالسلام ، وفي عدمه بإصالة عدم صدور النهي.
ولكن هذا خروج عن الاستدلال بالخبر، مع أنّه يمكن منع حجيّة هذا الاصل، نظراً الى العلم الاجمالي بصدور نواهي كثيرة عن أفعال، ومع العلم الاجمالي بخلاف الاصل لا يمكن التمسّك به.
إلاّ أن يقال: إنّ العلم الاجمالي بخلاف هذا الاصل بعد تبيّن الحكم في كثير من اطرافه لا حكم له بالنسبة إلى ما لم يعلم حاله من أطرافه فالرجوع فيها إلى مقتضى الاصل لا منع عنه.
والانصاف: ظهور الحديث في الاباحة الظاهرية في كل ما شك في حكمه، بملاحظة أنّ كون الأشياء مباحة اباحة مالكية من الضروريات التي يقضي به عقل كل عاقل، ولا فائدة في بيانها.
مضافاً إلى أن الخبر(٢) مروي عن الصادقعليهالسلام ، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الاباحة الظاهرية فيما لم يصدر نهي عنه أصلاً عن النبيّصلىاللهعليهوآله وأوصيائهعليهمالسلام ، فانّها ايضاً يمكن دعوى كونها من البديهيّات التي لا ينبغي الشك فيها، فحمل الخبر على أحد هذين الوجهين كأنّه إلغاء له وحمل له على مالا فائدة فيه أصلاً.
ومنها: قولهعليهالسلام في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي ابراهيمعليهالسلام قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة أهي ممّن لا تحلّ له أبداً؟ قال: لا أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها فقد يعذر الناس
____________________
(١) الظاهر « عنه » زائدة.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٣٧.
في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. قلت: بايّ الجهالتين أعذر؟ بجهالة أنّ ذلك محرّم عليه؟ أم بجهالة أنّها في عدّة ؟ قال: إحدى الجهالتين أهون من الاخرى، الجهالة بأنّ اللّه حرّم عليه ذلك، وذلك لأنّه لا يقدر معها على الاحتياط، قلت: فهو في الاخرى معذور؟ قال: نعم اذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوجّها(١) .
وجه الاستدلال: أنّه حكم بأنّ الجاهل بكونها في العدّة معذور ولا عقاب عليه في مواضع من الخبر:
الأوّل: قولهعليهالسلام : « اما اذا كان بجهالة » فانّ الظاهر أنّ المراد منها الأعم من الجهل بالحكم والجهل بكونها في العدّة، بقرينة سؤال الراوي عن الأعذرية، إذ هو انما يصحّ بعد الفراغ عن المعذورية في الصورتين، والظاهر أنّ الحكم بجواز التزويج انّما هو لأجل المعذورية في ارتكاب هذا النكاح، ويظهر ذلك من قولهعليهالسلام : « فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم ».
الثاني: قولهعليهالسلام : « احدى الجهالتين أهون من الاخرى » وهو صريح في اشتراك الجهالتين في أصل المعذورية.
الثالث: قولهعليهالسلام نعم في جواب قولهعليهالسلام : « فهو في الاخرى معذور » فانّ الجهل بكونها في العدّة كما يمكن أن يكون شبهة في الموضوع، كذلك يمكن أن يكون شبهة في الحكم ولم يفصّل في مقام الجواب بين الصورتين، وذلك يدلّ على اشتراك الصورتين في المعذورية وعدم العقاب، ضرورة أنّه مع عدم الاشتراك يجب التفصيل.
والجواب: أنّ المراد من الخبر ليس هو المعذوريّة في ارتكاب النكاح في العدّة، من حيث المؤاخذة والعقاب الاخروي ليدلّ على الاباحة الظاهرية، بل المراد المعذورية في النكاح بعد انقضاء العدّة، فالمراد منها عدم حرمتها عليه مؤبّداً بفعل
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٤ ج ١٤ ص ٣٤٥، والاستبصار: ج ٣ ص ١٨٦ ح ٣ مع اختلاف يسير فيهما.
هذا النكاح مع الجهل.
ويدلّ على ما ذكرنا: مضافاً الى ظهور الخبر فيه، لقولهعليهالسلام : « نعم اذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها » أنّه يمتنع حمل المعذوريّة في الخبر على المعذوريّة في إرتكاب النكاح في العدّة جهلا من حيث المؤاخذة، لأنّ صور النكاح في العدّة مع الجهل بكونها في العدّة ليس فيها ما يكون الجاهل فيه معذوراً، فلابدّ من حملها على المعذورية في النكاح بعد العدّة.
بيان ذلك: أنّ الجهل بالعدّة تارة: للجهل بمقدار العدّة، وتارة: للجهل بأنّ المرأة مزوّجة يجب عليها التربّص، وتارة: للشك في انقضاء العدّة بعد العلم بأنّها مزوّجة يجب عليها التربّص، وتارة: للغفلة، أو لاعتقاد انّها غير معتدّة، أمّا النكاح في الاولى: فلا شك في انّه غير جائز لأنّ الأصل بقاء العدّة وكذلك الأصل بقاء أحكامها، وكذا في الثالثة، وأمّا الثانية: فالظاهر أنّه ايضاً كذلك، لأنّ الاصل عدم تأثير العقد، ولأنّه يجب الفحص، وأمّا في الأخيرتين: فالنكاح وإن لم يكن محرّماً، إلاّ أنّ حمل الجهل بالعدّة عليها يوجب عدم الفرق بين الجاهل بأنّها محرّمة، والجاهل بأنّها في العدة، لأنّه على هذا التقدير يكون الثاني ايضاً غير قادر على الاحتياط.فان قلت: إنّ الحكم كلّية بأنّ الجاهل بأنّها محرّمة لا يقدر على الاحتياط وجعله وجهاً للفرق تفكيك بين الجهالتين، مع أنّه يتصوّر في كل منهما القدرة على الاحتياط على بعض التقادير وعدم القدرة على بعض التقادير إذ الشاك بالحرمة قادر على الاحتياط كما أنّ الغافل عن كونها في العدة غير قادر على الاحتياط.
قلت: وضوح الحكم بين المسلمين ليس بمثابة يمكن معها أن يقال: إنّ من دخل في المسلمين قد يشك في ذلك، لأنّ حرمة النكاح في العدّة في الوضوح كوجوب الصلاة، فالمسلمون بين غافل عن الحرمة، وعالم بها، ولا يتصوّر أن يوجد فيهم شاك في ذلك، فانحصر على ذلك صورة الجهل بانّها محرّمة عليه في الجهل عن غفلة وهذا هو الذي أوجب التفكيك بين الجهالتين فتأمّل.
ومن الاخبار: قولهعليهالسلام : كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال
حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه(١) .
وجه الاستدلال كما عن شرح الوافية: أنّ كلّ فعل من جملة الأفعال التي تتّصف بالحلّ والحرمة، وكذا كلّ عين ممّا يتعلّق به فعل المكلّف ويتّصف بالحلّ والحرمة اذا لم يعلم الحكم الخاص به من الحلّ والحرمة فهو حلال، فخرج ما لا يتّصف بهما جميعاً من الأفعال الاضطرارية، والأعيان التي لا يتعلّق بها فعل المكلّف، وما علم أنّه حلال لا حرام فيه، أو حرام لا حلال فيه، وليس الغرض من ذكر الوصف مجرّد احتراز، بل هو مع بيان ما فيه الاشتباه، فصار الحاصل: أنّ ما اشتبه حكمه، وكان محتملاً لأن يكون حلالاً، ولأن يكون حراماً، فهو حلال، سواء علم حكم كلي فوقه أو تحته بحيث لو فرض العلم باندراجه تحته أو تحققه في ضمنه يعلم حكمه أم لا.
وبعبارة اخرى: انّ كل شيء فيه الحلال والحرام عندك بمعنى انّك تقسمه إلى هذين، وتحكم عليه بأحدهما لا على التعيين ولا تدري المعيّن منهما، فهو لك حلال، فيقال: الرواية صادقة على مثل اللحم المشترى من السوق المحتمل للمذكى والميتة، وعلى شرب التتن، ولحم الحمير - إن لم نقل بوضوحه وشككنا فيه - لأنّه يصدق على كل منهما انّه شيء فيه حلال وحرام عندنا بمعنى أنّه يجوز لنا أن نجعله مقسماً لحكمين فنقول: هو إمّا حلال وإمّا حرام، وأنّه يكون من جملة الأفعال التي بعض أنواعها وأصنافها حلالاً وبعضها حراماً واشتركت في ان الحكم الشرعي المتعلّق بها غير معلوم انتهى(٢) وحاصله: أنّ الشيء عام يشمل الأعيان الخارجية والأفعال، ولا ريب أنّ الاولى لا يعقل أن يجتمع فيه حلال محقّق وحرام، فالمراد من قوله: « فيه حلال وحرام » فيه احتمال الحرمة لصلاحيته لأن يتّصف بهما، وليس المراد من الصلاحية، الصلاحية بالنظر الى نفس الشيء ليخرج من القيد خصوص ما لا يمكن
____________________
(١) من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٣٤١ ح ٤٢٠٨.
(٢) شرح الوافية: ص ٥٦ س ٨.
اتّصافه بالحلّ والحرمة من الافعال الاضطراريّة، ضرورة أنّ المقصود بيان منشأ الاشتباه، فالمراد: الصلاحية في نظر المكلّف، ملاحظة حال الفعل في نفسه من كونه اختيارياً، وملاحظة عدم وجود دليل يقتضي اختصاص أحد الوصفين به.
فظهر أنّ معنى قوله: « كل شيء فيه حلال وحرام » كلّ ما اشتبه حكمه، لاحتماله لأن يكون حلالاً ولأن يكون حراماً، ولا ريب أنّ هذا العنوان يشمل جميع الشبهات الموضوعية التحريميّة، والشبهات الحكمية التحريميّة.
والجواب: ان الشيء لا يصحّ أن يكون المراد منه ما يعمّ الأفعال والجزئيات الخارجية، لأنّ إرجاع الضمير إليه في قوله: « حتى تعرف الحرام منه » يقتضي وجود القسمين فيه فعلاً، والجزئي لا يعقل وجود القسمين فيه، فيجب أن يكون المراد من الشيء الأفعال والأعيان على وجه الكلية، أو خصوص الاولى، لرجوع اتّصاف الأعيان بالوصفين إلى اتّصاف الاعيان بهما، أو خصوص الجزئيات الخارجية، وارتكاب الاستخدام في ضميري « فيه » و « منه » بارجاعهما إلى نوع ذلك الجزئي، ومعه يتمحّض الرواية في بيان حكم الشبهة في الموضوع، لأنّه لا داعي الى مخالفة ظاهر قوله: « فيه حلال وحرام » وحمله على المعنى الذي ذكره، بل لو فرضنا عدم وجود قوله: « منه » - كما في بعض النسخ - لم يكن مخالفة ظاهر قوله: « فيه حلال وحرام » أولى من اختصاص الشيء بالكليات أو إبقائه على حاله، وارتكاب الاستخدام في الضمير، بل لا يخفى أولوية ما ذكرناه.
هذا مع انه يرد على المستدلّ: أنّه مع فرض شمول الشيء للأفعال التي اشتبه حكمها، فليس ما يوجب تعميم الشيء بحيث يشمل الأعيان، لامكان إرجاع الاشتباه فيها إلى الاشتباه في الفعل المتعلّق بالاعيان، بل يتعيّن ذلك على هذا التقدير، لأنّ اتّصاف الاعيان الخارجية بها مجوّز من باب توصيف الشيء بوصف متعلّقه فيلزم على ما ذكره استعمال قوله: « فيه حلال وحرام » في معنيين، لا لما يأتي، بل لأنّ احتمال الحلّ في المعنيين مجاز، واحتمال الحلّ في الفعل حقيقة.
والحاصل: أنّه لو حملنا قولهعليهالسلام : « فيه حلال وحرام » على قابلية الحلّ
والحرمة، ودفعنا الاشكال الآتي، يأتي إشكال آخر، وهو: أنّ قابلية العين للحلّ باعتبار فعل تعلّق به وقابلية الفعل لنفسه، فاسناده إليهما يوجب استعمال اللفظ في معنى حقيقي ومجازي، ولا جامع بين قابلية العين وقابلية الفعل حتى يستعمل في ذلك، فلابدّ في الخبر من إرتكاب أحد الأمرين:
إمّا إبقاء الشيء على ظاهره، وهو الجزئي الخارجي، ومعه يجب إرتكاب الاستخدام، لانّ ظهور قوله: « فيه حلال وحرام » على ما ذكره المستدلّ خلاف الظاهر، ولا يناسب ضمير « منه » في قوله: « حتى تعرف الحرام منه ».
وإما حمله على الكلي وصرفه إلى الأفعال فينحصر الخبر في بيان حكم الشبهة في الموضوع، والمعنى على الأوّل: كلّ جزئي في نوعه قسم حلال وقسم حرام، وشكّ في ذلك الجزئي للشك في إندراجه في كلّ من القسمين، يكون ذلك الجزئي حلالاً حتى تعرف انه يكون ذلك الجزئي من القسم الحرام من النوع، وعلى الثاني: كلّ كلي فيه قسم حلال وقسم حرام، يكون ذلك الكلي حلالاً حتى تعرف الحرام منه، وتعرف أنّه يكون الكلي متحقّقاً في القسم الحرام منه.
ثم انّه قد يوجّه الاستدلال بالخبر لاثبات المدّعى - بعد الاعتراف بأنّ الظاهر من قوله: « فيه حلال وحرام » وجود القسم الحلال والقسم الحرام فعلاً - فانّا نفرض كلّياً له قسمان: قسم حلال، وقسم حرام، ونفرض قسماً ثالثاً منه مشكوك حكمه، فنقول: ذلك الكلّي المفروض حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه.
ولا يخفى ما فيه بعد ما أشرنا إليه من أنّ فائدة قوله: « فيه حلال وحرام » بيان منشأ الاشتباه، ولا ريب أن الاشتباه في مثله لم ينشأ من وجود قسم حلال وقسم حرام لذلك، وانّما الاشتباه من جهة عدم الدليل الدالّ على حكم ذلك القسم الثالث، فلا ينبغي الحكم بحلّه ظاهراً تمسّكاً بهذا الحديث، وانّما هو داخل في عموم قوله: « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي »(١) على تقدير تماميّة دلالته، مع أنّ على
____________________
(١) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٣٧.
هذا التوجيه يتمّ الاستدلال في كلّ مشتبه، إذ لا محالة مندرج في عنوان كلّي يكون قسم منه حراماً، وقسم منه حلالاً، ولا أقلّ من عنوان فعل، أو أكل، أو شرب، فلا وجه لاختصاصه ببعض الموارد دون بعض، كما حكي عن الموجّه.
وقد يورد على المستدلّ بالحديث: بانّه على ما ذكره يلزم إستعمال قوله: « فيه حلال وحرام » في معنيين: أحدهما: فيه قابلية الحلّ والحرمة، والآخر: فيه حلال محقّق وحرام محقّق، إمّا في نفس الأمر، أو عندنا، وهو غير جائز.
وبأنّه يلزم على ما ذكره استعمال قوله: « حتى تعرف الحرام منه » في معنيين: أحدهما: حتى تعرف من الأدلّة الشرعيّة، اذا كان المشتبه كلّياً مجهول الحكم. والثاني: حتى تعرف من الخارج، اذا كان الاشتباه من الامور الخارجية، ولا يخفى ما فيه.
هذه جملة ما يمكن الاستدلال به من الأخبار، ولابدّ - على تقدير تماميّة دلالتها - ملاحظتها مع ما يدلّ على الاحتياط، وعلاج التعارض بينهما على مقتضى قواعد العلاج، ومعرفة ما يجب العمل به منهما.
وأمّا الاجماع: فتقريره من وجهين:
الأوّل: أنّ الحكم فيما لم يرد دليل نقلي أو عقلي على كونه محرّماً - من حيث هو هو لا من حيث كونه مجهول الحكم - البراءة باجماع المجتهدين والاخباريين كافّة، ولا ريب انّ هذا الاجماع لا يثبت به شيء الاّ بعد إبطال جميع ما به يستدلّ على وجوب الاحتياط، فانّ ادنى ما يتّصف باعتبار من الادلّة اذا دلّ عليه، يكون وارداً على هذا الاجماع.
بل ربما يناقش بأنّه إجماع على أمر عقلي ولا يكشف ذلك عن رأي المعصومعليهالسلام ، لجواز أن يكون كلّ حاكماً بالبراءة بمقتضى حكم عقله واستكشاف رأي المعصوم من الاتّفاق انّما هو في غير المستقلات العقلية، إذ فيها لا يمكن الجزم بأنّ إتّفاقهم على ذلك نشأ من العلم برأي الحجّة، لجواز أن يكون ذلك الاتّفاق لحكم عقل كل واحد على طبق ما حكم به عقل الباقين، ومع هذا الاحتمال
لا يحصل العلم برأي الحجّةعليهالسلام من اتّفاقهم، وإن حصل من بداهة الحكم عند العقل.
الثاني: دعوى اتّفاق العلماء كافّة على أنّ الحكم في الشبهة التحريمية فيما لم يرد فيه نصّ هو البراءة وعدم وجوب الاحتياط، كالشبهة الوجوبية والموضوعية، ويمكن تحصيله من وجوه:
الأوّل: ملاحظة فتاواهم، إذ لم ينقل من زمان المحدّثين إلى زمان أرباب التصنيف الفتوى بحرمة شيء بمجرّد إحتمال حرمته مع عدم الدليل عليه.
وربما يقال: إنّ الحكم بالبراءة انّما حدث من زمان متأخّري المتأخّرين، ولعلّه رأي ما يتمسّك به من الاحتياط في طي الاستدلال.
ولا ريب انّ ذلك انّما هو وجه التأييد، فانّهم يتمسّكون به في الشبهة التحريمية والوجوبية التي يسلّم الاتّفاق فيها على عدم وجوب الاحتياط.
ففي عقائد الصدوق، اعتقادنا أنّ الاشياء على الاباحة حتى يرد النهي(١) ، والظاهر موافقة والدهرحمهالله ومشائخه له، فان عند مخالفتهم لا يعبّر بذلك، وانّما يقول: الذي أعتقده، أو أفتي به.
وعن الكليني: التصريح بانّ الحكم فيما اختلف فيه الاخبار التخيير(٢) .
والظاهر: أنّ بناءه فيما نحن فيه أيضاً على البراءة، لأنّ الأمر بالاحتياط في خصوص ما تعارض فيه النصّان وارد، ولم يرد نص بالاحتياط في خصوص ما لا نصّ فيه، إلاّ أن يقال: انّه لا ملازمة بين القول بعدم وجوب الاحتياط فيما اختلف فيه الأخبار، والقول به فيما لم يرد فيه نصّ، لأنّه كما ورد هناك أخبار آمرة بالاحتياط، كذلك ورد أخبار تدلّ على أنّ الحكم هو التخيير، فيمكن أن يكون المفتي بالتخيير هناك، إنّما يفتي به لترجيح الأخبار الدالّة على التخيير عنده على الأخبار الخاصة الدالّة على وجوب الاحتياط هناك، وعلى الأخبار الدالّة على وجوب الاحتياط في
____________________
(١) اعتقادات الصدوق (ضمن شرح باب الحادي عشر) : ص ١٠٧.
(٢) الكافي: ج ١ ص ٩ (خطبة الكتاب).
عموم الشبهة، ولا يفتي به فيما لم يرد نصّ فيه، لضعف أخبار البراءة عنده دلالة أو سنداً، ولقوّة أخبار الاحتياط عند المعارضة عنده، لكونها مخالفة للعامة، فانّ بناء قاطبتهم على البراءة فيما لا نصّ فيه.
والانصاف: أنّ ظهور الفتوى بالتخيير هناك في الافتاء بالبراءة فيما نحن فيه لا يمكن منعه.
مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ عدم الفرق بين الشبهة التحريمية التي تعارض فيه النصّان وبين ما لم يرد فيها نصّ يقضي بأنّ المفتي بالتخيير في الأوّل يفتي بعدم وجوب الاحتياط في الثانية:
ولكن يدفعه: أنّ عدم الفرق مع وجود من لا يعلم منه عدم الفرق ممنوع، لامكان أن يكون هو الفارق، فلا يمكن استنباط فتوى بعض العلماء لعدم الفرق من ملاحظة إفتاء غيره بعدم الفرق، لاحتمال أن يفرق.
وعن السيّدين: التصريح بانّه متى لم يوجد الدليل على حكم الواقعة، فالمرجع هو حكم العقل(١)(٢) . وعن العدّة: حكم الأشياء من طريق العقل وإن كان هو الوقف، لكنّه لا يمنع أن يدلّ دليل سمعي على أنّ الاشياء على الاباحة بعد أن كانت على الوقف بل عندنا الأمر كذلك وإليه نذهب(٣) . وعن الحلّي: دعوى أنّ الرجوع إلى الحكم العقل عند فقد الدليل، ممّا اتّفق عليه المحقّقون الباحثون عن مآخذ الشريعة(٤) . وأمّا المحقّق(٥) ، والعلامة(٦) والشهيدان(٧) ، وغيرهم، فرجوعهم على البراءة عند فقد الدليل، أوضح ما يستفاد من كتبهم.
____________________
(١) رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاولى: ص ٣١٨.
(٢) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٤٦١.
(٣) عدة الاصول: في بيان الأشياء المحظورة والمباحة ص ٢٩٦.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٤٦.
(٥) معارج الاصول: ص ٢٠٥ و ٢٠٦.
(٦) مبادئ الوصول: ص ٩٣.
(٧) تمهيد القواعد: ص ٣٧، القواعد والفوائد: ج ١ ص ٥٥.
وبالجملة: لا أظن أحداً - بعد المراجعة إلى كتب الفقهاء وملاحظة فتاواهم وطريقة إستدلالهم - يدّعي أنّ العمل بالبراءة لم يكن ممّا جرت عليه طريقة السلف والخلف، وانّما أنكر ذلك بعض الأخباريّين.
الثاني: الشهرة المحقّقة - بعد كونها منضمّة إلى الاجماعات - إذ بعد إنضمامها يحصل القطع كثيراً باتّفاق الطائفة، ويمكن إستظهار دعوى الاجماع من عبارة الصدوق السابقة(١) وعن أوّل السرائر: - بعد ذكر الكتاب، والسنّة، والاجماع -: إذا فقدت هذه الثلاثة، فالمعتمد في المسألة الشرعية عند المحقّقين الباحثين عن مآخذ الشريعة: التمسّك بدليل العقل(٢) . وعن المحقّق في باب الاستصحاب من المعارج: دعوى إطباق العلماء على ذلك(٣) . وعنه ايضاً - في توجيه نسبة السيّدرحمهالله إلى هذه مذهبنا جواز إزالة النجاسة بالمضاف مع عدم ورود نصّ فيه - : أنّ من أصلنا: العمل بالأصل حتى يثبت الناقل ولم يثبت المنع عن إزالة النجاسة بالمضاف(٤) .
والظاهر أنّ مراده من الاصل - لمقابلة الناقل - أصالة البراءة، لأنّه الاصل الذي يسمّى الدليل بموافقته له مقرّراً، وبمخالفته ناقلاً، ولو لا أنّ هذا الأصل إجماعي، لم يحسن جعل ذلك وجهاً لدعوى اتّفاق السيّد، وأمّا الشهرة: فيكفي في تحقّقها، فتوى من عرفت من الأساطين.
الثالث: الاجماع العملي الكاشف عن رضا المعصومعليهالسلام ، فانّ سيرة المسلمين من أوّل الشريعة: على عدم الالزام بترك ما يحتمل ورود النهي عنه بخصوصه، بعد الفحص والتتبّع التام، وطريقة الشارع كان إبلاغ المحرّمات، ولو لا أنّ الاباحة يكفي فيها عدم النهي، كان الواجب تعداد المباحات دون المحرّمات.
وأمّا العقل: فبيانه أنّ ممّا يستقلّ به، هو قبح التكليف بدون بيانه، فانّ صحّة
____________________
(١) اعتقادات الصدوق (ضمن شرح باب الحادي عشر): ص ١٠٧.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٤٦.
(٣) معارج الاصول: ص ٢٠٨.
(٤) المعتبر: ج ١ ص ٨٦.
العقاب على مخالفة الأمر والنهي، موقوف عند العقل على أحد الأمرين: إمّا علم المكلّف بهما، وإمّا تمكّنه من طريق يوجب العلم بالخطاب، أو طريق أوجب الآمر العمل بذلك الطريق في تشخيص أوامره ونواهيه تعبّداً، ومع عدم ذلك كلّه، يكون العقاب على مخالفة ذلك الأمر فعلاً قبيحاً مندرجاً في عنوان الظلم والعدوان، وهو قبيح عند كلّ عاقل من جميع الأديان، والمراد من تمكّنه من الطريق: كونه فعلاً قادراً على تحصيل العلم بخطاب المولى، أو العلم بما نصبه لتشخيص أوامره ونواهي لمن لا يتمكّن من تحصيل العلم، أو مطلقاً.
وذلك موقوف أوّلاً: على كونه ملتفتاً بحيث يكون احتمال التكليف قائماً عنده.
وثانياً: على وجود طريق يوجب العلم، أو طريق تعبّدي يقدر المكلّف على الوصول إليه وتحصيله، إذا كان في مقام الاطاعة والانقياد فمن يكون فاقد الأمرين، أو فاقد أحدهما لا يكون ذلك مكلّفاً، ولا يصحّ على الحكيم بل على كلّ عاقل أن يعاقب على مثل هذا المكلّف على مخالفة الأمر والنهي.
ولا يتفاوت الأمر في قبح العقاب على مثل هذا المكلّف، بين أن يكون عدم تمكّنه من الطريق لعدم نصب الطريق، وبين أن يكون لعدم وجوده عنده لإخفاء الظالمين، ومجرّد قيام إحتمالوجود طريق يتمكّن المكلّف بسبب ذلك الطريق من الوصول الى مطلوب المولى عنده واختفي ذلك عنه، لا يكون حجّة عليه عند العقلاء، وموجباً لحسن مؤاخذته على مخالفة ما أمر به المولى في الواقع، أو نهى عنه.
نعم لو علم بأنّ للمولى أحكاماً، وعلم أنّه جعل لها طريقاً منصوباً واختفي ذلك، كان الاحتياط واجباً، لكن لا لأجل علمه بنصب الطريق، بل لعلمه بوجود الأحكام، فانّه بيان له، إذ البيان أعم من التفصيلي والإجمالي - لما يأتي - والحاصل: أنّ العقل مستقلّ بقبح العقاب على مخالفة الأمر اذا كان المكلّف غير واجد للعلم، أو ما يقوم مقامه، وغير متمكّن من تحصيل العلم وما يقوم مقامه، ويعدّ عند العقلاء من يعاقب مثل هذا المكلّف الذي لا يكون واجداً لما ذكر، ظالماً فاعلاً للقبيح.
لا يقال: إنّ وجوب دفع الضرر المحتمل بيان عقلي للتكليف المجهول.
لأنّا نقول: إن اريد من الضرر المحتمل، العقاب على مخالفة الحكم الواقعي المشكوك وجوده على تقدير وجوده فيرد عليه: أنّ احتماله - بعد استقلال العقل بقبح التكليف بدون بيان، وإتمام حجّة - ممنوع، وانّما يكون احتمال وجود الحكم ملازماً لاحتمال العقاب على إرتكاب مشوك الحرمة، وترك مشكوك الوجوب، إذا كان العقاب على مخالفة الحكم من اللوازم العقلية لوجود الحكم واقعاً، والعقل مستقلّ بعدم هذه الملازمة.
والحاصل: أنّ إندراج فعل مشكوك الحرمة فيما يحتمل الضرر على إرتكابه، موقوف على عدم كونه ممّا لا بيان لحكمه الواقعي، ضرورة انّه مع القطع بانه ممّا لا بيان لحكمه، والقطع بقبح العقاب بدون بيان، والقطع بكون المكلّف حكيماً لا يفعل الاّ ما يطابق الحكمة يكون عدم العقاب قطعيّاً، فلو كان دخول مشكوك الحكم من غير طريق عقلي غير قاعدة وجوب دفع الضرر، ومن غير طريق تعبّدي، فيما لا يكون حكمه الواقع مبيّناً موقوفاً على عدم كونه ممّا يحتمل ترتّب الضرر عليه، لزم الدور، ضرورة أنّه على ذلك يتوقّف اندراج المشكوك في موضوع كل من القاعدتين على عدم اندراجه في موضوع القاعدة الاخرى وعدم اندراجه في موضوع كل قاعدة، على إندراجه في موضوع الاخرى، وهو بديهيّ البطلان، فعلم انّه لا يتوقّف إندراجه في موضوع القاعدة الثانية سبباً لعدم إندراجه في موضوع القاعدة الاولى ويكون اندراجه في موضوع القاعدة الثانية مع عدم اندراجه في موضوع القاعدة الاولى ويكون اندراجه في موضوع القاعدة الثانية سبباً لعدم اندراجه في موضوع القاعدة الاولى هذا مع أنّ هذه القاعدة - على تقدير تماميّتها، والقطع باندراج الحكم المشكوك في موضوعها - لا تتضمّن بيان الحكم الواقعي المشكوك، كيف والشك في ذلك الحكم - على هذا التقدير - مأخوذ في موضوعها، فيكون مفادها حكماً ظاهرياً، نظير القواعد المبيّنة للأحكام الظاهرية، كالاستصحاب ووجوب الاحتياط في محلّ النزاع عند القائلين به.
وإن اريد من الضرر المحتمل: المفاسد اللازمة لذات الفعل الداعية إلى إنشاء الحكم التي لا يختلف ترتّبها على الفعل باعتبار إختلاف حال الفاعل بالنسبة إلى جهله بتلك المفسدة وعلمه بها، ففيه: أنّ وجوب دفع تلك المفاسد وإن كان بحكم العقل ثابتاً إلاّ أنّه لمّا لم يوجب وجود تلك المفسدة الاّ إنشاء حكم واحد وقد حصل الاّ من حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان من ترتّب العقاب على مخالفة ذلك الحكم المجهول، لم يترتّب على هذا الحكم العقلي خطاب شرعيّ فعليّ يخاف من ترتّب العقاب على مخالفته ومع عدم ثبوت حكم لدفع هذا الضرر، لا يكون شيء ملزم للمكلّف على اختيار ما يطابق الاحتياط، وترك ما لا يطابقه، إذ المفروض: أن العقاب مأمون منه ولا ملزم غيره.
فان قلت: إنا نقطع بأنّ لبعض الافعال والتروك مفاسدً تعلّق غرض المولى بعدم وقوع العبيد في تلك المفاسد، ومع هذا يعلم بحكم العقل بأنّ العبد متى يحتمل عنده كون الفعل ذا مفسدة يجب عليه الاجتناب عن ذلك الفعل لأنّه يحكم عليه بأنّه يجب عليه اذا علم أن غرض المولى عدم وقوعه في تلك المفاسد أن لا يصير سبباً لوقوعه في تلك المفاسد وسبباً لنقض غرض المولى، إذ نقول: انّ مع العلم بأن غرض المولى عدم وقوع العبيد في مفاسد الافعال، نعلم بأنّه أوجب على المكلّف عند احتمال اشتمال الفعل على مفسدة، الوقوف والاجتناب عن ذلك الفعل حفظاً لنفسه عن الوقوع في المفسدة، لأن عدم ايجاب الاحتياط مناف لتعلّق غرضه بعدم وقوع العبد في المفاسد على جميع التقادير.
والحاصل: إنّا نقطع بأنّ بعض الأفعال فيها مفاسد تعلّق غرض المولى بعدم وقوع العبيد في تلك المفاسد مطلقاً، ومع هذا العلم إمّا يحكم العقل بوجوب الاحتياط، أو يستكشف إيجاب الشارع الاحتياط، لأنّ عدم ايجابه نقض لغرضه نظير وجوب العمل بالظن عند إنسداد باب العلم والظن الخاص وعدم وجوب الاحتياط، فانّه إما يحكم العقل بوجوب العمل بالظن، أو يستكشف من بقاء التكليف وعدم صحّته من غير نصب الطريق وعدم طريقيّة غير الظنّ ممّا يحتمل أن يكون طريقاً
بالاجماع أنّ الظن واجب العمل، وعلى أيّ حال يجب الاحتياط على المكلّف.
ثم إنّ استكشافه فيه ايجاب الاحتياط ايضاً أعم من ايجابه الاحتياط وجوباً نفسيّاً، أو وجوباً طريقياً لا يترتّب على مخالفته العقاب إلاّ على تقدير كون مخالفته موجباً للهلاك والوقوع في المفسدة - على ما مرّ بيانه في الاستدلال بحديث الرّفع -.
قلت: أما حكم العقل بوجوب الاحتياط على المكلّف، فلا يكفي فيه مجرّد علم المكلّف بأنّ غرض المولى تعلّق بعدم وقوع العبيد في مفاسد الافعال، بل الموجب لذلك علمه بأنّ المولى أراد منه أن لا يوقع نفسه في المهالك كيف ما كان، علم بوجود الهلاك وترتّبه على الفعل أم لا، ومع عدم علمه بأنّه أراد منه ذلك وإن علم(١) بأن يكون غرض المولى تعلّق بعدم وقوعهم فيها لا نحكم بذلك، لأنّ الذي يجب على العبد ويستقلّ بوجوبه العقل هو أن يكون مطيعاً للمولى، بأن يشتغل بما يأمره به، ويجتنب عمّا ينهاه عنه، ولا يستقلّ بوجوب شيء زيادة على المكلف به فما دام المكلّف لا يكون عالماً بأنّ المولى أراد منه تحصيل غرضه وكلّفه بذلك، لا يستقلّ بوجوب الاحتياط، بل مع عدم كون تحصيل أغراص المولى من الواجبات على العبد عنده، يستقل بأنّه لا يجب عليه تحصيل الغرض اذ يجب على الشارع بيان ذلك التكليف، إما بلسان العقل، أو بغيره، والمفروض أنّ العقل لا بيان له، وليس ايضاً بيان غيره، فذمّة المكلّف بريء حال الجهل بذلك التكليف عن ذلك التكليف، وعن التكاليف الواقعية الناشئة عن تلك المفاسد، لأنّها ايضاً مجهولة بالغرض.
والحاصل: أنّه اذا علم المكلّف بأنّ المولى أراد منه تحصيل أغراضه مطلقاً، وجب عليه الاحتياط لأجل أن يحصل له العلم بفراغ ذمّته عن ذلك التكليف، إذ
____________________
(١) في نسخة اخرى بين كلمة « وإن علم » وبين « بأن يكون » توجد هذه العبارة: بأن يكون التفصيلي سبباً لزوال الاجمالي السابق وانقلابه الى شك بدوي وعلم تفصيلي وقد لا يكون كذلك، فعلى الأوّل لا يجب الاحتياط في مشكوك الحكم وعلى الثاني يجب الاحتياط.
وضابط القسمين: هو أنّ متعلّق الخطاب المعلوم المفصّل متعلّقه، إمّا أمر لا يحتمل عدم انطباق متعلّق الخطاب المعلوم إلى علم.
مع احتمال أن يكون في فعل مفسدة لم يحترز عنه لا يقطع بفراغ ذمّته، وكذلك الأمر إذا علم اجمالاً بوجود محرّمات بين الأفعال ومع عدمها لا يجب الاحتياط، وأمّا استكشافه ايجاب الشارع الاحتياط على أحد الوجهين، فهو مبنيّ على العلم بأن تلك المفاسد التي نشأ منها الاحكام لا يكون قابلة للتدارك بعمل مستحب أو غيره، اذ مع احتمال أن يكون تلك المفاسد متداركة، لا يمكن الجزم بايجاب الاحتياط والحاصل: أنّ تعلّق الغرض بعدم وقوع العبد في تلك المفاسد يوجب احد الأمرين إما ايجاب الاحتياط في موارد احتمال المفسدة وإمّا تداركها حال الجهل بأمر من الامور ولا يمكن تعيين أحد الأمرين إلاّ بدليل، فغاية ما يستكشفه العقل من العلم بتعلّق الغرض المذكور أنّها متداركة، أو يكون الاحتياط واجب، فايجاب الاحتياط وتعيينه يحتاج إلى دليل، وحيث لا دليل عليه، يقطع بعدم العقاب على تركه، إذ لو كان مطلوباً فعله، لوجب البيان، ولا بيان، فلا عقاب.
ويمكن تقرير الاشكال بوجه آخر لا يندفع بما ذكر، وبيانه: أنّ اشتمال بعض الأفعال على مفاسد يكون وقوع المكلّف فيها ضرراً عليه ممّا لا ريب فيه فمتى حصل القطع بوجود المفسدة يحكم العقل بوجوب الاحتراز عنه، وكذلك الأمر مع إحتمال وجودها، ضرورة أنّ دفع الضرر المحتمل كدفع الضرر المقطوع واجب، فعن الشيخ: الإقدام على ما لا يؤمن المفسدة كالإقدام على ما لا يعلم المفسدة فيه(١) . وعن ابن زهر: الجزم(٢) بذلك، ومجرد إحتمال تدارك المفاسد لا يكفي في رفع حكم العقل لوجوب دفع تلك المفاسد، لأنّ مناط حكمه احتمال وجود المفسدة وهو ما لم يحصل القطع بتداركها باق غير مرفوع، ومع حكم العقل بالوجوب يحكم الشرع ايضاً بوجوب دفع تلك المفاسد المحتملة بقاعدة الملازمة.
ثم انّ حكم العقل بوجوب الاحتراز عن محتمل المفسدة تارة لأجل كونه
____________________
(١) عدة الاصول: فصل في بيان الأشياء المحظورة ص ٢٩٦ مخطوط.
(٢) الغنية: (ضمن الجوامع الفقهية) ص ٤٦٣.
موضوعاً مستقلاً، حكمه عنده وجوب الاحتراز عنه، وتارة لأجل أنّه على بعض تقاديره، وهو تقدير احتمال مطابقة الضرر للواقع يجب الاحتراز عنه والفرق بين الوجهين: أنّ كل ما يحتمل الحرمة إن طابق احتمال الحرمة للواقع، يكون الاحتراز عنه واجباً على الوجهين، وإن خالف فلا يكون الاحتراز عنه واجباً على الثاني واقعاً، لأنّ الواجب هو الاحتراز عن المفسدة بناءً عليه ولا مفسدة في هذا المشكوك، وانّ ما حكم العقل به حكماً إرشادياً لأجل أن يحصل القطع بالفرار عمّا يجب الفرار عنه، وعلى الأوّل يكون واجباً، لأنّ المفروض أنّ محتمل المفسدة من حيث هو كذلك - مع قطع النظر عن مطابقة احتمال اشتماله للضرر الواقع - كان حكمه وجوب الاحتراز فهو الفرد الذي يحتمل اشتماله على المفسدة يجب الاحتراز عنه واقعاً.
ومن هنا علم أنّ حكم العقل على التقدير الأوّل لاستلزامه حكم الشرع بوجوب الاحتراز فعلاً عمّا يشتمل على المفسدة لو كان في موارد الشبهة ما يشتمل عليها واقعاً سبب لتنجيز الأحكام الواقعية المخالفة للاصل في موارد الشبهة لو كانت، لأنّه يحصل منه ومن قاعدته الملازمة الحرمة بانّ الشارع يريد العمل على طبق تلك الاحكام حال كونها مشكوكة الثبوت، وهذا أبلغ بيان للحكم.
وامّا ما قد سبق من أنّ العقل يحكم بأنّ تلك الاحكام حال الجهل بها لا يكون منجّزة، والمفاسد الواقعية لا يوجب إنشاء حكمين حتى يكون رفع أحدهما للجهل به غير ملازم لثبوت الآخر بقاعدة الملازمة.
ففيه: أنّ حكم العقل بعدم تنجّز تلك الأحكام مع قطع النظر عن حكمه بوجوب الاحتراز عن محتمل المفسدة وحكم اللّه على طبق حكمه، وأمّا مع ملاحظة حكمه وما يلزمه من حكم الشارع، فلا يحكم بعدم تنجّز تلك الأحكام لأنّ حكمه بعدم تنجّزها انّما كان لأجل عدم البيان، والمفروض حصول البيان، وليس حكم الشارع بوجوب الاحتراز عمّا فيه المفسدة على طبق حكم العقل حكماً آخر غير الحرمة الواقعية الثابتة لذوات الأفعال، بل هي هي غير انها بينت بلسان العقل.
فان قلت: كيف يكون حكم العقل بوجوب الاحتراز عن المفاسد الواقعية فعلاً على أيّ تقدير، وحكم الشارع على طبقه بقاعدة الملازمة بياناً للأحكام المجهولة في موارد الشبهة ان كانت هناك احكام مع وجودها مع هذا الحكم ايضاً مشكوكة.
والحاصل: أنّ بيانها عبارة عن نصب طريق عقلي أو تعبّدي إلى ثبوتها، ولا طريق إلى ثبوتها.
قلت: البيان الذي يكون بدونه العقاب قبيحاً ليس هو هذا البيان، بل هو عبارة عن الأعم من ذلك ومن بيان ارادة الحركة على طبق الحكم الواقعي المحتمل على تقدير ثبوته، ضرورة انه مع بيان الشارع وكذلك كل مولى انّى اريد الاحتياط في موارد الشبهة، لأن لا يحصل مخالفة احكامه الواقعية لا يقبح العقاب على تقدير حصول المخالفة بترك الاحتياط. وقد مرّ بيان ذلك في تقدير وجوب الاحتياط على وجه الطريقية في حديث الرفع، وأمّا على تقدير الأولّ فهو حكم ظاهري وقاعدة ظاهرية مانعة عن العمل بالاباحة الظاهرية التي يقتضيها أدلّة البراءة، نظير الاستصحاب في موارد البراءة.
وعلى أيّ تقدير فلا يحكم العقل بقبح العقاب. لا يقال: يمكن دفع الاشكال بهذا التقرير اذا بني على الوجه الثاني من وجهي ايجاب الاحتياط، وبيانه: أن وجوب الاحتياط عند العقل على هذا التقدير وجوب إرشادي لمصلحة في غيره، وهذا لا يتبعه إلاّ حكم إرشادي لا يترتّب على مخالفته لا ما يترتّب على نفس مخالفة المأمور به من الوقوع في المفاسد الواقعية، وانّما الذي يكون واجباً ويترتّب على مخالفة العقاب هو الايقاع في المفاسد، لأنّه يأمر به العقل ارشاداً لنفسه، فيتبعه أمر الشارع كذلك وهو يستلزم استحقاق العقاب على مخالفته، فالذي يترتّب العقاب عليه من الخطابين هو الخطاب بالاحتراز عن المفاسد دون الخطاب بالاحتياط، والمفروض أنّ وجود المفسدة في كل واحد من المشتبهات غير معلوم، والاّ خرج عن كونه مشكوك الحكم، فيكون وجوب الاحتراز عن كل مشتبه وجوباً شرعياً يترتّب على مخالفته استحقاق العقاب غير معلوم، للشك في اندراجه في موضوع الخطاب المعلوم،
ومع هذا يكون الشبهة موضوعيّة لا يجب الاحتياط فيها باتّفاق الأخباريين والاصوليّين.
بل نقول: يمكن دفع الاشكال على الوجه الأوّل من ايجاب الاحتياط ايضاً، لأنّ إندراج الاحتياط في موضوع الخطاب بالاجتناب عن المفاسد الواقعية مشكوك فلا يجب الاحتياط، لأنّ الشبهة فيه من الشبهة في الموضوع، وعدم وجوب الاحتياط فيها ينافي الحكم بوجوب الاحتياط في المحتمل من حيث هو فتأمّل.
لأنّا نقول: إنّ الشبهة الموضوعية التي وقع الاتّفاق فيها من العلماء على عدم وجوب الاحتياط، هي الشبهة الناشئة من الاشتباه في الامور الخارجية، دون مثل هذه الشبهة، بل الظاهر أنّ ما يسمّونه شبهة في الموضوع هو الأول دون الثاني، وعلى تقدير شمول الاسم فليس كل شبهة في الموضوع لا يجب الاحتياط فيها بالاتّفاق.
فالأولى في الجواب عن هذا الاشكال: التمسّك بالأخبار الخاصّة الدالّة على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية، كحديث الرفع(١) ، ومرسلة الفقيه(٢) ويقال: انّ مع إذن الشارع في ترك الاحتياط، يحصل لنا القطع بعدم الضرر، لأنّ الإذن فيما لا يؤمّن من ترتّب الضرر عليه لا يصح، إلاّ على تقدير تدارك تلك المفسدة على تقدير وجودها، وهذا هو الوجه في عدم وجوب الاحتياط في الشبهة في الموضوع، هذا كلّه إذا أراد القائل بوجوب دفع الضرر - من الضرر - المضارّ الاخروية من العقاب وغيره.
وإن أراد من المضارّ الدنيوية منها.
ففيه: انّ وجوب دفع الضرر الدنيوي وإن كان ثابتاً بالخطابات اللفظية، كقوله تعالى: « ولا تلقوا »(٣) وغيره، إلاّ أنّ اندراج المشكوك في موضوع تلك الخطابات مشكوك، وقد مرّ مراراً أنّ الاحتياط في الشبهات الموضوعية لا يكون
____________________
(١) الخصال: ج ٢ ص ٤١٧ ح ٩.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٣٧.
(٣) البقرة: ١٩٥.
واجباً بالاتّفاق.
نعم لو كان الاحتمال بالغاً حدّ الظن- بحيث يصدق على عدم الاحتياط معه الايقاع في التهلكة - لم نضايق من القول بوجوبه.
وعن الغنية: ان التكليف بما لا طريق الى العلم به تكليف بما لا يطاق(١) . وتبعه بعض من تأخّر واستدلّ به للبراءة.
ولا ريب انّ هذه القضية بظاهرها غير صحيحة، لأنّ المكلّف بمجرّد عدم كونه عالماً بأنّ الفعل مكلّف به، لا يخرج عن الاختيار ولا يصير صدور الفعل عنه خارجاً عمّا يطيقه.
نعم إن كان المأمور به هو الفعل بقصد الاطاعة - بحيث يكون الخصوصية المذكورة مأخوذة في المأمور به - كان الأمر كما ذكره، ضرورة أنّ الفعل بقصد الاطاعة انما يتمكّن منه المكلّف إذا كان قصد الاطاعة ممكناً، ومع الجهل بالأمر لا يمكن، ضرورة أنّ كون الشيء داعياً للفاعل، وباعثاً لاختياره، انّما يمكن اذا كان قاطعاً بترتّبه على ما يختاره.
ولكن لا يخفى أنّ قصد الامتثال لا يكون داخلاً في المأمور به - كما قرّر في محلّه - وانّما هو من الأغراض الباعثة على صدور التكليف، سواء كان الأمر تعبّدياً، أو توصّلياً، فانّ الغرض في الأوامر التوصلية بعثه على الفعل على تقدير عدم اختياره له بدواعيه النفسانية.
توضيحه: أنّ الغرض الأصلي من طلب الفعل - وهو إدراك المصلحة المترتّبة عليه - وإن كان يحصل بمجرّد الفعل لا عن قصد الاطاعة في الأوامر التوصلية، الاّ أنّ المكلّف إذا لم يكن داع له في الخارج لا يصدر منه الفعل فيفوت الغرض، ولا يحسن من الآمر الاكتفاء بما يحصل منه في بعض الاحيان اتّفاقاً، فيجب عليه أن يكلّف بالفعل، ليكون تكليفه باعثاً على اختيار الفعل عند فقدان داع غيره حتى تتم
____________________
(١) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٤٦٤.
الحجة على المكلّف، ولا يفوت - بسبب اهمال الشارع - من المكلّف شيء من المصالح. فتأمّل.
فتلخّص أنّ الغرض من الأوامر مطلقاً هو حصول الفعل بقصد الاطاعة، إلاّ أنّه في التوصليات ليس حصول الفعل عن ذلك القصد دائماً من الأغراض، بل انّما يكون حصوله عن ذلك القصد غرضاً إذا لم يكن للمكلّف ما يوجب القصد الى الفعل وصدوره منه من الامور الخارجية وقد عرفت أنّ الغرض انّما يترتّب على العلم بالأمر فالتكليف بما لا طريق الى العلم به حقيقة تكليف لا يطابق امتثاله، ولعلّ ذلك مراد السيد(١) ايضاً.
ولكن لا يخفى أنّ الاستدلال بذلك في مسألة البراءة لا يصحّ، إلاّ إذا فرض انحصار الغرض في ذلك، فانّه لو قلنا: إنّ حصول الفعل باحتمال أن يكون مأموراً به يصحّ أن يكون من الأغراض المقصود ترتّبها على التكليف، لا يمكن نفي التكليف بمجرّد عدم إيمكان قصد الاطاعة إلاّ أن يقال: إنّ احتمال وجود التكليف واقعاً، إن قام عند المكلّف وثبت عنده دليل على وجوب ارتكاب الفعل عند احتمال التكليف كان ذلك التكليف معنياً عن التكليف الواقعي وان لم يكن عنده دليل فلا ريب ان التكليف الواقعي لا يترتب عليه هذا الغرض.
فتلخّص أنّ التكليف المجهول لا يمكن أن يكون الغرض منه بعث المكلف حال الجهل على الفعل، لعدم إمكان أن يكون هو الباعث على صدوره من المكلّف، فهو في تلك الحال لا يكون ثابتاً.
وقد يستدلّ للبراءة باستصحاب براءة الذمّة حال الصغر:
والاستدلال بذلك: إن كان الاستصحاب معتبراً لافادة الظن ببقاء الحالة السابقة وجيه، لأنّ الاذن في العمل بذلك الظن يوجب البناء ظاهراً على ثبوت الحالة السابقة، ويلزمه عدم العقاب فيما يلزمه عدم العقاب، والعقاب فيما يلزمه
____________________
(١) المصدر السابق.
استحقاق العقاب كما لا يخفى، ولكن الحق خلافه.
وإن كان معتبراً للأخبار الدالّة على وجوب البناء على الحالة السابقة ففي صحّة التمسّك به هنا إشكال، لأنّ الغرض هنا تحصيل القطع بأنّ احتمال وجود الحكم على تقدير مطابقته للواقع لا يترتّب على مخالفة العقاب وهذا لا يحصل من الاستصحاب، لأنّ أدلّة اعتباره إنّما يقتضي ثبوت الآثار الجعلية للمستصحب في الحالة السابقة في حال الشك، وعدم إستحقاق العقاب على الترك في حال الصغر ليس من الآثار الجعلية لعدم الوجوب والرخصة في الترك، وان كان مستلزماً لما ذكر، إلاّ أنّه من المقارنات لعدم الوجوب لا من آثاره.
إلاّ أن يقال: إنّ أدلّة اعتبار الاستصحاب - كما يأتي - تدلّ على أنّ البناء على بقاء كل ما أمكن إثباته ورفعه بالجعل، ولم يكن ذلك من الامور العقلية التي لا تقبل الجعل واجب، وعدم وجوب الفعل من الامور القابلة للاثبات والرفع، فيجب البناء على بقائه عند الشك في رفعه.
والحاصل: أنّ أدلّة الاستصحاب ليس مقتضاه منحصراً في وجوب إثبات الآثار الجعلية للمستصحب، بل هي تقتضي فيما ليس بنفسه قابلاً للجعل والرفع وجوب إبقاء آثاره الشرعية - كما في الموضوعات الخارجية - وفيما يكون بنفسه قابلاً للجعل والاثبات والرفع - كالوجوب وعدم الوجوب، والاباحة وعدم الاباحة - وجوب إبقاء ذلك الشيء ظاهراً والبناء على ثبوته، ويستلزم الأمر بالبناء على بقاء الحالة السابقة استحقاق العقاب على ترك الفعل مطلقاً، أو على تقدير مصادفة إحتمال وجوبه للواقع - إن كان المستصحب وجوب شيء - ويستلزم استحقاق العقاب على الترك - إن كان المستصحب عدم وجوب شيء - فثبت من إستصحاب عدم وجوب الفعل في حال الصغر، عدم وجوبه ظاهراً في حال الشك في انتقاض ذلك العدم، ويترتّب عليه عدم استحقاق العقاب على مخالفة الحكم الواقعي لو كان ثابتاً فتأمّل.
ثم إنّه قد يورد على الاستصحاب بأنّ موضوع البراءة الاصلية السابقة، هو
الصغير الذي لا يكون قابلاً لأن يكلّف، وهو مقطوع مغايرته مع من يستصحب الحكم، وهذا أشبه بالقياس، فانّ إشتراط بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب من المسلّمات، بل حقيقته منوطة به - كما يأتي -.
ويشكل بأنّ هذا الكلام انما يتوجّه إذا اريد من الاستصحاب، إثبات الحكم العقلي الثابت حال الصغر، ضرورة أنّ موضوعه - كما ذكر - الصغير الذي لا يميّز، ولا يكون قابلاً للتكليف، وهو معلوم الارتفاع.
وأمّا اذا اريد من الاستصحاب إثبات الحكم الشرعي الذي هو على طبق الحكم العقلي الذي لم يكن مستفاداً من قاعدة الملازمة، بل من سائر أدلّة الاحكام من الكتاب والسنّة والاجماع، فلا وجه بهذا الاشكال فانّ موضوع ذلك ليس هو الصغير الذي لا يميّز، بل هو ذات المكلّف، لا بعنوان أنّه مكلّف، غاية الأمر إنّ ثبوت ذلك الحكم في حال الصغر يقيني وفي حال عدمه مقطوع الارتفاع بالنسبة الى بعض الافعال، فلا يمكن استصحابه، ومشكوك الارتفاع بالنسبة إلى بعض الافعال، فيستصحب إلى أن يعلم خلافه.
وقد يستدلّ للبراءة بأنّ الاحتياط عسر.
وفيه المنع (أوّلاً) لأن ذلك انّما يكون من كثرة الموارد، وهي غير مسلّمة خصوصاً بالنظر إلى مذهب الأخباري، فانّه انّما يذهب إلى الاحتياط، كما قيل في خصوص الشبهة التحريمية فيما لا نص فيه، وفيما تعارض فيه النصّان مع عدم مرجّح منصوص، ولا ريب أنّ هذه الموارد قليلة لا يلزم من الاحتياط فيها حرج.
(وثانياً) انّ ذلك لا يوجب المصير إلى البراءة، بل الواجب الاحتياط في غير ما يظنّ بعدم التكليف فيه، ويعمل بالبراءة هنا دفعاً للحرج وترجيحاً له على ما يشكّ في عدم التكليف فيه.
وبالجملة: فمقتضى القاعدة إذا كان الاحتياط الكلي مستلزماً للحرج، التبعيض - على الوجه الذي اتّضح تقريره في آخر دليل الانسداد لحجية مطلق الظن -.
القول في أدلّة القول بوجوب الاحتياط والكفّ عمّا يحتمل حرمته وهي الكتاب والسنّة والعقل
أمّا الكتاب: فالمستدلّ منه به طائفتان: الاولى: الآيات الناهية عن القول بغير علم، كقوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم)(١) ومنه قوله تعالى (فان تنازعتم في شيء فردّوه إلى اللّه والرسول)(٢) فانّ الظاهر أنّ المراد من الردّ - واللّه العالم - : السكوت وعدم القول فيه بشيء وانتظار ما يأتي به الرسولصلىاللهعليهوآله ، فعدّ الآية من الطائفة الثانية كما في الرسائل(٣) غير خال من النظر.
الثانية: الآيات الآمرة بالاحتياط كقوله تعالى: (اتّقوا اللّه حق تقاته)(٤) (وجاهدوا في اللّه حق جهاده)(٥) (فاتقوا اللّه ما استطعتم)(٦) (ولا تلقوا)(٧) إلى آخره.
والجواب أمّا عن الأوّل: فبأنّ الفتوى بالاباحة الظاهرية - مستنداً إلى ما يدلّ على البراءة من قبح التكليف بلا بيان وغيره من الأدلّة اللفظية - ليس قولاً بغير علم، فالدالّ على البراءة وارد على هذه الآيات.
وأمّا عن الثانية: فبأنّ دلالة ما عدا آية التهلكة على الوجوب ممنوعة، مضافاً إلى أنّ منافاة إرتكاب المشتبه للتقوى والمجاهدة إنّما نسلّم، إذا كان ما يدلّ على الرخصة
____________________
(١) الإسراء: ٣٦.
(٢) النساء: ٥٩.
(٣) فرائد الاصول: ٣٣٩.
(٤) آل عمران: ١٠٢.
(٥) الحج: ٧٨.
(٦) التغابن: ١٦.
(٧) البقرة: ١٩٥.
فيه غير موجود، ومع وجوده فلا منافاة ضرورة أنّ المنافي لهما فعل ما لا يرضى به اللّه تعالى، فما ثبت أنّه راض به لا ينافيها.
وأمّا آية التهلكة فيما مرّ من أنّ الضرر الاخروي بقسميه مأمون منهما، وما يحتمل الضرر الدنيوي خارج عن مدلول الآية.
ودعوى: أنه قد يكون داخلاً كما اذا قام خبر ظنّي غير معتبر على حرمة شيء ويتمّ الباقي بعدم القول بالفصل، لا اظنّ انّها مسموعة، لانّ استلزام الخبر الظنّي الدالّ على الحرمة الظنّ بالضرر الدنيوي - على تقدير إفادته الظنّ بالحرمة - بديهي العدم ولا إجماع على الفرق بين صورة الظن بالضرر الدنيوي وغيره حتى يتمّ مطلوب الخصم.
وأمّا السنّة فهي أيضاً طوائف: الاولى: ما يدلّ على النهي عن القول بغير علم، كقوله تعالى (وأن تقولوا على اللّه ما لا تعلمون)(١) ومن ذلك قولهعليهالسلام : وأمر اختلف فيه فردّوه إلى اللّه عزّ وجلّ(٢) . وقولهعليهالسلام : حق اللّه على العباد أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا عند ما لا يعلمون(٣) .
فانّ الظاهر ان المراد: التوقّف عن القول دون العمل وإن استلزمه، وعدّهما فيما يدلّ على وجوب التوقّف لا يخلو من نظر.
والجواب: ما مرّ في الآيات.
الثانية : ما يدلّ على وجوب التوقّف كالأخبار المشتملة على أنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة(٤) .
وكرواية الطيّار عن الصادقعليهالسلام انه قالعليهالسلام عند عرض بعض خطب اللّه عليه وبلوغه موضعاً منها: كفّ واسكت ثم قالعليهالسلام : انه
____________________
(١) البقرة: ١٦٩.
(٢) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب صفات القاضي ح ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ ج ١٨ ص ٨٦ اختلاف فيه.
(٣) الكافي: ج ١ ص ٤٣ ح ٧.
(٤) وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب صفات القاضي ح ٢ و ٩ و ١٣ و ١٥ ج ١٨ ص ١١٢.
لا يسعكم فيما ينزل بكم الاّ الكفّ والتثبّت والردّ الى ائمة الهدى حتى يحملوكم فيه إلى القصد ويجلوا عنكم فيه العمى ويعرّفوكم فيه الحق(١) .
وكرواية المسمعي الآمرة بالكفّ والتثبّت عند تعارض الخبرين واختلافهما بعد الأمر بالردّ الى ائمة الهدى والنهي عن القول بالرأي(٢) إلى غير ذلك.
واجيب بوجوه:
الأوّل: إن أخبار البراءة أخصّ من أخبار التوقّف فيخصّص بها.
وفيه: إن أخبار البراءة لا تكون قابلة لمعارضة أخبار الاحتياط، لورودها عليها - كما مرّ - وأمّا بعض الأخبار الخاصة: كقوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي(٣) فهي وإن اقتضت البراءة فيما لا نصّ فيه، إلاّ أنّ ادلّة التوقّف دلالتها على وجوب الاحتياط فيما يتعارض فيه النصّان تامّة من غير معارض، لفقدان ما يصلح للمعارضة عدا هذا الخبر، وهو مختصّ بالبراءة فيما لا نصّ فيه، فانّ ما ورد فيه نصّان متعارضان، حصل فيه غاية الاباحة الظاهرية الدالّة عليها هذا الخبر وهي ورود النهي، وحينئذٍ فيتمّ أخبار التوقّف لما لا نصّ فيه، وان اقتضى هذا الخبر تخصيصها، لعدم القول بالفصل.
والحاصل: أنّ عموم العام في غير مورد التعارض سليم عن المعارض، فيجب العمل به ويتمّ المطلوب في مورد المعارضة، لعدم القول بالفصل، فانّ العمل بالخاص في قبال العام انما يصحّ إذا لم يعارضه دليل آخر، والاجماع المنضمّ إلى العموم بالنسبة الى غير مورد التخصيص معارض للخاص هنا.
إلاّ أن يقال: كما يمكن إتمام مقصود الأخباري بالعمل بالعموم في غير مورد المعارضة وفيه بعدم القول بالفصل، كذلك يمكن إتمام مقصود الاصولي بالعمل
____________________
(١) الكافي: ج ١ ص ٥٠ ح ١٠. مع اختلاف فيه.
(٢) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب صفات القاضي ح ٢١ ج ١٨ ص ٨١.
(٣) وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب صفات القاضي ح ٦٠ ج ١٨ ص ١٢٧.
بقاعدة تعارض العموم والخصوص في مورد المعارضة، واتمام المقصود في غير مورد التعارض بعدم القول بالفصل، فكما يمكن أن يعمل بدليل الاحتياط فيما تعارض فيه النصّان، ويتمسّك للعموم فيما لا نصّ فيه بالاجماع المركّب، كذلك يمكن العكس، وهو إتمام ادلّة البراءة الخاصة بظاهرها بما لا نص فيه لما تعارض فيه النصّان بالاجماع المركّب.
بل يمكن أن يقال: إنّ هذا أولى، لأنّه يستلزم ابقاء حكم العام في بعض مصاديقه، كما في الشبهة المحصورة، بخلاف العكس فانّه يستلزم الغاء ادلّة البراءة بالمرّة.
ولكن يرد عليه: انّ ابقاء عموم العام في بعض مصاديقه الذي لا يمكن إرادته من العموم خاصة، لاستلزام تخصيص العام في أكثر مصاديقه مثل طرح العموم بالمرّة، وليس ذلك موجباً لترجيح العمل بالاجماع المركّب في طرق أخبار البراءة دون أخبار الاحتياط.
ويمكن أن يقال: إنّ قولهعليهالسلام : كل شيء مطلق إن فرض غايته ورود مطلق النهي فهو بنفسه يردّ نفسه، لأنّ مفهومه يقتضي الاحتياط فيما يتعارض فيه النصان، لأنّه يدلّ على حصر الاباحة الظاهرية في غير صورة ورود النهي الأعم من النهي المعارض بغيره ومن الذي لا معارض له كما هو المفروض، وحينئذٍ فإن اخذنا بمفهومه، وجب طرح منطوقه بالاجماع، وإن انعكس الأمر، وجب طرح مفهومه بالاجماع، وهذا الخبر لا يصلح للمعارضة لتلك العمومات الدالّة على وجوب الاحتياط. ويأتي تتمة الكلام إن شاء اللّه بعد الدليل العقلي وردّه.
وأمّا العقل: فيقرّر بوجهين: الأوّل إنّا نعلم قبل المراجعة إلى أدلّة الأحكام: أنّ من الأفعال ما يكون محرّماً في الواقع ولا يريد الشارع أن يصدر تلك الأفعال من المكلّفين، ومقتضى هذا العلم الكفاية في تنجّز الخطاب المعلوم بالاجمال، وفي جواز العقاب على مخالفة الخطاب المعلوم بحكم العقل، الاحتياط في جميع اطراف الشبهة حتى يحصل القطع بفراغ الذمّة عن ذلك التكليف المعلوم بالإجمال الذي حسن
العقاب على مخالفته عند العقل، لأنّ تحصيل البراءة اليقينية عن الاشتغال اليقيني واجب بحكم العقل ثم انّا بعد المراجعة لم يحصل لنا القطع بمحرّمات بمقدار المعلوم بالاجمال بحيث يوجب ذلك القطع بزوال العلم الاجمالي في غير المقطوعات، بحيث يكون الشك فيها شكّاً بدوياً. وأمّا ما دلّ على حرمة الأدلّة الظنية فهي وإن كانت بمقدار المعلوم بالاجمال، بل يمكن أن يقال: انّها أكثر الاّ أنّ الحرمة الظاهرية المعلومة بالأدلّة الظنية لا يوجب رفع حكم العقل في موارد الشبهة بالاحتياط الاّ إذا كان الأمر بالعمل بالأدلّة متضمّناً لبيان اكتفاء الشارع في مقام امتثال الخطاب المعلوم بالاجمال بالعمل بمؤدّياتها.
والجواب عنه بوجوه:
الأوّل: انّا لا نعلم بوجود محرّمات في الأفعال بحيث تكون الأفعال التي لم يقم طريق على حرمتها داخلة في أطراف الشبهة، بل العلم الاجمالي الموجود هو العلم بوجود محرّمات في ما قام الطريق على حرمتها، إذ مع إلقاء بعض الأفعال التي لا طريق على حرمتها بمقدار المعلوم بالاجمال الذي يدّعى وجودها في المجموع لا يزول العلم الاجمالي بوجود المحرّمات في مؤديات الطرق، ومع إلغاء بعض ما قام الطريق على حرمتها بمقدار المعلوم بالاجمال في المجموع، لا يبقى لنا علم إجمالي بوجود محرّمات في البعض الباقي، ممّا قام الطريق على حرمتها وغيرها من الأفعال التي لم يقم طريق على حرمتها.
والحاصل: أنّ من يدّعي وجود العلم الاجمالي بالمحرّمات في الأفعال:
إمّا أن يدّعي علماً إجمالياً واحداً وهو العلم بمحرمات في الافعال الاعم ممّا قام الطريق على حرمته وممّا لم يقم طريق على حرمته.
أو يدّعي أنّ لنا علماً إجمالياً بوجود محرّمات بين الأفعال زيادة على المقدار الذي نعلم وجودها في مؤدّيات الطرق، فإن اقتصر في مقام الدعوى على الأوّل.
فجوابه: أنّ إلقاء بعض الأفعال التي لم يقم طريق على حرمتها بمقدار المعلوم بالاجمال لا يوجب زوال العلم الاجمالي، وهذا دليل على أنها خارجة عن اطراف الشبهة
وإن ادّعى البراءة(١) ، فجوابه: أنّ القاء بعض ما قام الطريق على حرمتها بمقدار ما يعلم وجودها من المحرّمات في مؤدّيات الطرق خاصة يوجب زوال العلم الاجمالي في غير ما القي في موارد الطرق وسائر الأفعال التي لا طريق على حرمتها، وهذا دليل عدم وجود العلم الاجمالي بالزائد الذي ادّعاه، لأنّه لو كانت محرّمات زائدة على المقدار المعلوم وجوده في الطريق، لم يلزم من فرض عدم ما يكون بمقدار ذلك المعلوم وجوده في مؤدّيات الطريق عدم العلم الاجمالي.
وهذا الجواب انّما يفيد إذا ادّعى إن أطراف الشبهة في العلم الاجمالي الذي يدّعى انحصارها في ما قام الطريق خصوص ما قام الطريق المعتبر على حرمته، فانّه إذا كان من اطراف الشبهة ما قام على حرمته طريق غير معتبر، لم يمكن التمسّك فيه بالبراءة بل يمكن إتمام الاحتياط فيما لا نصّ فيه اصلاً بعدم القول بالفصل ان ثبت كما هو الظاهر.
الثاني: إن العلم بوجود المحرّمات مع ورود أدلّة البراءة لا يوجب الاحتياط، لأنّ هذا العلم الاجمالي ليس خاصاً وجوده بمن هو في زماننا - اعني زمان قطع الأيدي عن الوصول الى الائمةعليهمالسلام - بل كان متديّن بهذا الدين يعلم أنّ فيه أحكاماً وفي الأفعال يكون محرّمات وواجبات، ويعلم أيضاً أنّ في بعض الأفعال محرّمات ولا يحتمل عنده وجوب شيء منها، وكذا يعلم بأنّ بعض الأفعال فيها واجبات، ويعلم بأنّ شيئاً منها ليست بمحرّمة، ولا ريب أنّ أدلّة البراءة ليس المخاطب بها خصوص من حصل له العلم بمحرّمات بمقدار المعلوم بالاجمال بحيث زال بسبب ذلك علمه الاجمالي.
بل يمكن أن يقال: إنّ مثل هذا الشخص نادر وجوده لا يمكن أن يكون المقصود بالأخبار بيان حكمه، فعلم أنّ أخبار البراءة كلّها واردة في بيان عدم وجوب الاحتياط في موارد الشبهة من الاطراف الذي ليس فيه بخصوصه دليل على حكمه،
____________________
(١) الظاهر « الزيادة » بدل « البراءة ».
ولا ريب أنّ إذن الشارع بعدم وجوب الاحتياط في بعض أطراف الشبهة وإن لم يوجب رفع العلم الاجمالي، موجب لرفع حكمه - وهو وجوب الاحتياط - لأنّ مبناه هو احتمال الضرر مع اذن الشارع لا يحتمل وجود الضرر فيرتفع موضوع حكم العقل، فتأمّل.
الثالث: أنّ قيام الطريق على حرمة أفعال بمقدار المعلوم حرمته بالاجمال ممّا لا ريب فيه، وهذا يوجب رفع حكم العلم الاجمالي عمّا لا طريق الى حرمته، وبيانه يحتاج إلى مقدّمة.
وهي أنّ العلم اذا تعلّق بثبوت حكم لأحد الفعلين من الحرمة أو الوجوب مثلاً، ولم يكن علم للمكلف بعنوان ينطبق على موضوع ذلك الحكم الاّ عنوان أحدهما، أو عنوان آخر ينطبق على كل واحد من المشتبهين كفعل مثلاً، ولا ريب أنّ هذا العلم الاجمالي موجب لتنجّز الواقع إن كان المحرّم الواقعي كما زعمه المكلّف بمقدار المعلوم بالاجمال، كما إذا زعم أنّ أحد الغنمين موطوء، وكان في الواقع موطوءً ايضاً منحصراً في واحد، وموجباً لتنجّز الواقع بمقدار المعلوم اجمالاً على نحو التخيير بين أفراد الواقع اذا كان المحرّم الواقعي أزيد ممّا علمه المكلّف - كما في المثال - وكان كل منهما في الواقع محرّماً، فانّ الذي يجب عليه منجّزاً هو الاجتناب عن احد الغنمين على نحو التخيير، ضرورة أنّ العقاب على مخالفة الزائد عن الواحد عقاب بدون بيان بالفرض، وإذا حصل للمكلّف بعد هذا العلم الاجمالي علم بحرمة أحد الفعلين، أو أحد الغنمين تفصيلاً فهو على قسمين: أحدهما أن يحصل له العلم التفصيلي بحكم أحدهما بواسطة حصول سبب جديد للحكم، أو يعلم بالحكم، ويحتمل أن يكون سبب هذا الحكم امراً حادثاً فالأوّل: كما اذا علم أنّ أحد الغنمين موطوء ثم صار أحدهما المعيّن موطوءً وعلم به، والثاني: كما إذا أخبره أحد بانّ الغنم الفلاني موطوء وحصل له من قوله العلم، ولكن احتمل عنده أن يكون إخبار المخبر لعلمه بوطءٍ حادث غير ما علمه السامع، ومن هذا القبيل لو علم لموضوع الحكم عنواناً لا ينطبق الاّ على واحد منهما واقعاً واشتبه عليه الانطباق، ثم حصل له علم بأنّ المشتبهين له
حكم على طبق الحكم المعلوم بالاجمال لكن بسب آخر، أو مع احتمال كونه بسبب آخر، كما اذا علم أنّ أحد الصوتين غناء، ثم علم بعد ذلك أنّ المعيّن منهما صوت الأجنبية - إن قلنا بحرمة سماعها - والحكم في جميع هذه الصور هو الاحتياط في الطرف الذي بقي اشتباه حكمه، لأنّ الاشتغال بالاجتناب عن المعلوم بالاجمال حاصل، وهو يستدعي البراءة اليقينية، ولا يحصل ذلك الاّ بالاجتناب عن كلا الفردين.
فان قلت: انّ المعلوم ثبوته من التكليف بعد هذا العلم التفصيلي ليس إلاّ تكليفاً واحداً وهو حرمة المعلوم حرمته بالتفصيل، والاصل براءة الذمة عن الزائد.
قلت: اشتغال الذمة بالاجتناب المردد بين المشتبهين ثابت بمقتضى العلم الاجمالي الأوّلي، بل نقول: العلم بوجوب الاجتناب عنه الآن باق وسبب كون التكليف المعلوم الآن منحصراً في الواحد ليس بزوال ذلك العلم الاجمالي وصيرورته تفصيليّاً بل السبب في ذلك احتمال انطباق موضوع الحكم تفصيلاً لموضوع الحكم المعلوم اجمالاً.
وبعبارة اخرى العلم بوجوب الاجتناب عن الفرد المردّد بين المشتبهين حاصل والعلم بوجوب الاجتناب عن المحرّم المعلوم تفصيلاً أيضاً حاصل، ولكن لمّا كان انطباق المعلوم حكمه للفرد المردّد الذي علم حكمه محتملاً، لم يبق لنا علمان بتكليفين وصار ذلك سبباً لكون تكليف واحد معلوماً والزائد مشكوكاً، وإذا كان وجوب الاجتناب عن الفرد المردّد بين المشتبهين معلوماً، وجب بحكم العقل الاحتياط حتى يحصل البراءة اليقينية بعد الاشتغال اليقيني.
وأمّا قولك: إنّ الأصل براءة الذمّة عن الزائد، لا يجدي في رفع الاحتياط عن الفرد الذي بقي حكمة مشتبهاً، وذلك لأنّ براءة الذمّة - عند احتمال عدم انطباق الفرد المردّد له - معارض بأصالة براءة الذمّة عن المعلوم حكمه من هذه الجهة، - وإن كان الاشتغال به من جهة اخرى معلوماً - وبعد التعارض يتساقط الأصلان، إذ لا ترجيح بين الأصلين، - كما قرّر في محلّه -.
الثاني: أن يحصل العلم التفصيلي بحكم أحد المشتبهين على طبق الحكم المعلوم
بالاجمال، مع عدم كون العلم بالحكم بواسطة حدوث سبب جديد، ولا بواسطة أمر يحتمل معه حدوث سبب جديد، ولا ريب أنّ العلم الاجمالي في هذه الصورة ينقلب تفصيليّاً، فيكون المشتبه الآخر مشكوك الحكم بشك ابتدائي، وذلك لأنّ سبب إجمال العلم إنّما كان إشتباه متعلّق الحكم المعلوم، ولا ريب أنّه بعد هذا العلم يرفع الاشتباه، واذا رفع ينقلب الاجمالي الى التفصيلي، مثلاً اذا علمنا أنّ أحد الغنمين محرّم ولم نعلم المحرّم بخصوصه ثم علمنا بحرمة أحدهما خاصّة ولم يكن حدوث سبب الحرمة محتملاً، فلا ريب أنّ متعلّق الحرمة المعلومة يتعيّن كونه ذلك المعلوم حرمته تفصيلاً، ويبقى الفرد الآخر مشكوك الحكم ابتداء.
فتلخّص: أنّ العلم الاجمالي إذا لحقه العلم التفصيلي، فتارة يكون التفصيلي سبباً لزوال الاجمالي السابق وانقلابه الى شك بدوي وعلم تفصيلي، وقد لا يكون كذلك، فعلى الأوّل: لا يجب الاحتياط في مشكوك الحكم، وعلى الثاني: يجبب الاحتياط، وضابط القسمين: هو أنّ متعلّق الخطاب المعلوم المفصّل متعلّقه إمّا أمر لا يحتمل عدم إنطباق متعلق الخطاب المعلوم المجمل متعلّقه عليه، وإمّا أمر يحتمل أن لا ينطبق عليه، فعلى الأوّل: يذهب الاجمال من متعلّق العلم الاجمالي وينقلب تفصيليّاً، إلاّ إذا كان حدوث تكليف جديد عدا التكليف المعلوم بالاجمال محتملاً، فانّه لا تفصيل حينئذٍ لبقاء التردّد مع هذا الاحتمال في متعلّق الخطاب الأوّل، وعلى الثاني: يكون العلم بالخطاب المجمل باقياً على حاله، غاية الأمر أنّه للشك في الانطباق لا يكون التكليف المعلوم الاّ واحداً.
وبعبارة اخرى: إن كان جميع عناوين موضوع الحكم المجمل متعلّقه صادقاً على كل واحد من الأطراف، فيكون العلم بحكمه - مع عدم احتمال حدوث حكم جديد - موجباً لرفع اجمال العلم الأوّل، وإن لم يكن كذلك، فذهاب إجماله موقوف على العلم بثبوت عناوينه لبعض الاطراف، ففي ما اذا كان مفهوماً مردّداً بين مفهومين لا يصدق إلاّ على واحد منهما في الواقع، فحكمة الحرمة لا يذهب إجمال ذلك الحكم، الاّ بعد العلم بأنّ البعض المعيّن من الأطراف صادق عليه ذلك المفهوم
المردّد، ولا يكفي مجرّد العلم بأنّ الطرف الفلاني حكمه الحرمة لرفع الاجمال، لجواز أن يكون كل واحد من الأطراف الذي يكون مصداقاً لذلك المفهوم المردّد واقعاً وغيره حكمه الحرمة، ومع هذا الاحتمال كيف يرفع الاجمال.
وبعبارة ثالثة: المناط في رفع الإجمال من العلم هو العلم بأنّ متعلّق الحكم - الذي كان المكلف متردّداً في تعلّقه بكل من المشتبهين - هو البعض المعيّن منهما، وذلك عند كون جميع ما للمفهوم المردّد - الذي موضوع ذلك الحكم في نظر المكلف من العناوين - صادقاً على كل واحد من الأطراف، كمفهوم أحدهما، والفعل يحصل بمجرد العلم بثبوت الحكم المطابق لبعض الاطراف مع عدم احتمال تجدّد الحكم، وفيما إذا كان عنوان موضوع الحكم غير صادق في نظر المكلّف إلاّ على بعض لا يعلم ذلك البعض بتعيّناته، يجب أن يحصّل ما يرشده إلى مورد ذلك العنوان، ولا يكفي في رفع الاجمال العلم بكون بعض الاطراف مورداً لمثل الحكم الذي يثبت لذلك المجمل.
لا يقال: ما كرّرت من أنّ المفهوم الموضوع للحكم إن كان صادقاً على كل واحد من الاطراف، يكفي في رفع الاجمال،(١) العلم بثبوت مثل الحكم لبعض معيّن من الاطراف ممنوع، لأنّا قد يكون لنا علم بإباحة أحد فعلين، وعلم بحرمة الآخر مع اشتباه متعلّق العلمين، وليس في نظرنا عنوان لشيء من موردي الاباحة والحرمة إلاّ يصدق على كل من المشتبهين، ومع ذلك اذا علمنا بأنّ أحدهما المعيّن حكمه الحرمة، لا يحصل لنا العلم بإباحة الآخر ولو كان الأمر كما ذكرت للزم حصول العلم بإباحة الآخر.
لأنّا نقول: مع إحتمال تجدّد حكم ورفع إباحة المباح وثبوت الحرمة مكانها، اذ ذهاب العلم الاجمالي بالاباحة بنحوٍ آخر يمكن أن لا يحصل العلم بالاباحة وبدونه غير معقول.
____________________
(١) العلم (ظ).
لا يقال: ما تنجّز على المكلّف هو الاجتناب عن المحرّم الواقعي بذاته، لا الاجتناب عن شيء عنوانه أحدهما أو فعل ومع ذلك يجب أن يحصل العلم بأنّ البعض المعيّن الذي فصّل حكمه هو ذلك الواقع.
لانا نقول: حصول هذا العلم لازم تفصيل حكم أحد المشتبهين، لأنّ المحرّم الواقعي - الذي وجب الاجتناب عنه في مورد الشبهة - إما كلّ واحد من الأطراف، أو أحدهما، فان كان هو كل واحد، فالمنجّز على المكلّف لم يكن إلاّ أحدهما على وجه الترديد، وقد حصل له العلم بحرمة أحدهما بالمفروض، فحصل له العلم بالواقع الذي وجب الاجتناب عنه، وإن كان واحداً معيّناً، فالأمر فيه أوضح، إذ المفروض علم المكلّف بأنّ أحدهما محرّم.
إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: اذا علم المكلّف بأنّ مقداراً من الأفعال المردّد، وذلك المقدار الذي لا عنوان له إلاّ فعل في نظر المكلّفين، كعلمنا بأنّ للّه تعالى محرّمات بين الأفعال وقام الطريق على حرمة مقدار من الأفعال التي هي من أطراف الشبهة، فلا ريب أنّه يجب البناء على لزوم الاحتياط، وذلك لأنّ الطريق بمدلوله حاكم بأنّ الأفعال الخاصة محرّمات واقعية، ودليل وجوب العمل بالطريق يقضي بوجوب البناء على واقعية مدلول الطريق، فيكون تلك الأفعال محرّمات واقعية بحكم الشارع الجاعل للطريق، ولازم ذلك الحكم بانطباق المعلوم بالاجمال لما يدلّ على حرمة الطريق، إذ المفروض أنّ الواجب على المكلّف لم يكن إلاّ الاجتناب عن محرّمات واقعية، وقد فرض أن مؤدّى الطريق - المفروضة محرّمات واقعية بحكم الشارع - فهي بحكم الشارع تلك الواقعيات المنجّزة على المكلّف، فالاجتناب عنه يكون اجتناباً عن المحرمات الواقعية، فلا يجب الاحتياط في باق الاطراف.
توضيح ذلك: أنّ العلم الاجمالي بوجود الحرام بين الأطراف في مثل ما نحن فيه الذي لا عنوان فيه للمعلوم غير العنوان الصادق على جميع أطراف الشبهة، لا يوجب الاّ تنجّز الحرام الواقعي بمقدار المعلوم بالاجمال على المكلّف، إما تعييناً لو كان مقدار الحرام الواقعي بين الاطراف مطابقاً بمقدار المعلوم المكلف، أو تخييراً لو كان
أزيد، فاللازم على المكلّف إحراز الاجتناب عن المحرّم الواقعي الكائن بين الأطراف.
وطريق إحرازه: إمّا الاحتياط لو لم يكن طريق يثبت كون بعض الاطراف محرّماً واقعياً، ولو كان فإمّا هو العلم، وقد عرفت الكلام انّه موجب لزوال إجمال العلم بحدوثه لزوال سبب الاجمال، وهو تردّد المتعلّق للحكم بين الاطراف لانطباق المجمل حكمه على المفصّل حكمه، وإمّا هو طريق التعبّدية من خبر الواحد وغيره، وهو وإنّ لم يوجب زوال العلم الاجمالي، إلاّ أنّه كالعلم في رفع الاحتياط، لأنّ معنى حجّيته كون مؤدّاه منزّلاً منزلة الواقع عند الشارع، فما يدلّ على حرمة من الاطراف يكون محرّماً واقعياً بحكم جاعل الطريق، ويلزمه عقلاً الحكم بانطباق ذلك مع الذي اشتغل ذمة المكلّف به، اذ ليس عنوانه إلاّ المحرّم الواقعي بين الاطراف، وهو إمّا أحدهما أو كلاهما، والانطباق على الأخير واضح، وأمّا على الأوّل فلأنّ الحكم بأنّ أحد الأمرين الذين يعلم أنّ واحداً منهما حرام يكون حراما، يلزمه الحكم بأنّ هذا هو الحرام، إذ المفروض أنّه لا حرام الاّ واحد، فالمجتنب عنه يكون مجتنباً عن الحرام الواقعي الذي بين الاطراف عند جاعل الطريق، فإذا كان مجتنباً يسقط عنه الاحتياط، لأنّه انّما كان واجباً بحكم العقل، لأجل إحراز الاجتناب عن المحرّم الواقعي الذي كان بين الاطراف وكان ذمة المكلّف مشغولة به، وقد حصل إحراز ذلك بالاجتناب عمّا دلّ على حرمة الطرف.
والحاصل: أنّ الواجب على العالم اجمالاً لم يكن غير الاجتناب عن الحرام الواقعي الذي بين الاطراف، ممّا ثبت أنّه ذلك الحرام من الاطراف اذا احترز عنه فرغت ذمّته عنه، سواء كان ثبوته بطريق تعبّدي، أو عقلي، وعلى الأوّل يكون الطرف الآخر مشكوكاً حكمه حكم المشكوك الابتدائي، كما أنّه على الأخير حقيقة مشكوك بالشك الابتدائي فاصالة البراءة جارية فيه من غير مانع، ولكن لقائل أن يقول: إنّ الطريق لا يوجب التعيين، لأنّ معنى حجّيته ليس الاّ أن مؤدّاه واقع، وذلك لا يوجب الاّ ترتتيب الآثار الشرعية الثابتة الواقعية على مؤدّى الطريق،
ولا ريب أنّ الحرمة الواقعية الثابتة لبعض الاطراف، انّما يوجب ذلك سقوط العقاب على تقدير مخالفة أمر الاحتياط في الطرف الآخر على ترك الواقع المجهول بين الطرفين، لأجل أنّه على تقدير كونه واقعياً ينطبق على ما وجب على المكلّف منجّزاً، لأنّه إمّا واحد معيّن في الواقع بين الطرفين فهذا عينه، أو أحدهما المردّد على تقدير كون كل واحد منهما مردّداً حراما فهذا أيضاً ينطبق معه، وهذا السقوط الواقعي لا يكون كافياً في سقوط وجوب الاجتناب عن ذمّة المكلف الاّ بعد علمه بهذا الانطباق، أو ثبوته بطريق تعبّدي، وثبوت ذلك بالعلم بحرمة أحد الطرفين قد علمت وجهه، من أنّ ذهاب العلم الاجمالي بذهاب إحتمال عدم حرمة ذلك الطرف الذي علم حرمته، وحصول الانطباق بين المعلوم تفصيلاً والمجمل الذي علم حرمته، والطريق إنّما يثبت ذلك اذا كان مؤدّاه أنّ هذا الحرام الذي كان بين الطرفين، وأمّا بدونه فلا يثبت ذلك به، فانّ إنطباق حرمته طرف معيّن مع المجمل في نظر المكلّف انّما هو بسبب ذهاب إحتمال عدم حرمة ذلك الطرف، والطريق لا يسدّ باب الاحتمال.
فان قلت: الطريق وإن كان لا يسدّ باب الاحتمال، إلاّ أنّ معنى حجيته كون احتمال مخالفته للواقع منزّلاً منزلة العدم عند الشارع، ولازم ذلك الحكم بالانطباق كما اشرنا إليه.
قلنا: إنّ معنى كون الطريق حجة ليس الاّ انّه على تقدير كونه مطابقاً للواقع لا يكون المكلّف معذوراً في مخالفة الحكم الذي تضمّنه، أو الحكم الذي أثبت موضوعه كحياة زيد مثلاً وذلك لا ينافي وجوب الاحتياط لأجل العلم الاجمالي بحرمة أحد الطرفين.
وبالجملة: رفع الاحتياط من لوازم تفصيل العلم الاجمالي، والطريق التعبّدي لا يجعله بحكم المفصّل، لأنّه لا يثبت أنّه منطبق مع بعض الاطراف، لا بالمطابقة إذ عرفت أنّ مؤدّاه لا إشارة فيه إلى المعلوم بالاجمال فيما نحن فيه، ولا بالالتزام إذ ليس مدلوله الاّ سقوط العذر عن مخالفة الواقع.
القول فيما إذا علم بالتحريم بين امور محصورة
فالكلام في مقامين:
الأوّل
إنّه يحرم مخالفة القطعية وربما ينسب الميل الى جوازه الى بعض.
لنا على ذلك: ان المقتضي للتحريم موجود، والمانع عنه مفقود.
أمّا الأوّل: فلأنّ الأدلّة الدالّة على تحريم العناوين المحرّمة تشمل الموضوع المشتبه حتى على القول بأنّ الالفاظ أسام للامور المعلومة ، لأنّ الظاهر أنّ المدعّي لذلك لا يدّعي اعتبار التفصيل في الموضوع له.
وأمّا الثاني: فلأنّ العقل لا يأبى من النهي عن اجتناب أمر مشتبه بين امور محصورة ولا مانع من صحّته عنده، ولا يتصوّر في ذلك قبح يتوجّه الذمّ بسببه على المولى.
والحاصل: انه لا فرق عند العقل بين العلم الاجمالي والتفصيلي، فكما أنّه إذا علم متعلّق الخطاب تفصيلاً، وميّز عن جميع ما عداه عند المكلّف، يجب إمتثال الخطاب عنده ويستحقّ مخالفة العقاب لديه، كذلك إذا كان عند المكلّف مشتبهاً بين امور محصورة يمكنه امتثال الأمر أو النهي، ولا فرق عنده بين المقامين بوجه من الوجوه، ولا فرق عنده بين العاصي في هذا المقام وبين العاصي في المقام الأوّل، والشرع ايضاً لم يثبت منه منع عن مثل هذا التكليف، وأنّه عند اشتباه الحرام بغيره يرفع الحرمة ظاهراً.
وأمّا ما يتخيّل دلالته على المنع من قولهعليهالسلام : كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه(١) . وقولهعليهالسلام : كل شيء لك حلال حتى تعرف أنّه حرام بعينه(٢) . لأنّها كما تدلّ على حلّية المجهول حرمته مع عدم كونه من اطراف الشبهة كذلك على حلّية المجهول حرمته مع كونه من اطرافها، فلا دلالة فيه.
أمّا الأوّل: فلأنّ قولهعليهالسلام : فيه حلال وحرام ظاهر في بيان منشأ الاشتباه، والمعنى عليه: أنّ كل شيء يكون في نوعه قسمان، وصار ذلك الشيء مشتبه الحكم من جهة الشك في أنّ هذا الفرد من أيّ فرد ذلك النوع، لعدم دليل عند المكلّف يميّز به النوع الحلال عن النوع الحرام، يكون ذلك الشيء حلالاً حتى تعرف حرمته بشخصه، وهذا صريح في حكم الشبهة البدوية، ضرورة أنّ الشك في كل طرف من اطراف الشبهة المحصورة لم ينشأ من العلم بانقسام نوعه، أو فعلية إنقسامه الى النوعين، بل انّما نشأ من جهة اشتباه بعض الأشخاص الخارجية ببعض آخر.
والحاصل: ان الخبر ظاهر في بيان الأصل في بعض مصاديق الشبهات البدوية، وهي التي نشأ الشك فيها من العلم بانقسام النوع الى قسمين، ومن لاحظ صدر الخبر وجوابهعليهالسلام عن الراوي بقولهعليهالسلام ساخبرك عن الجبن وغيره، لا يبقى له شكّ في أنّ المقصود من الخبر: بيان حكم الشبهة البدوية.
وأمّا الثاني: فلأن معرفة شخص الحرام التي جعلت في الخبر غاية للحلّ، لا يكون غاية له على وجه يكون فيه خصوصيته، بل هو إحدى الغايات.
والحاصل: قوله « حتى تعرف انه حرام »، بمنزلة حتى يقوم دليل يوجب حرمته عليك وهذه الغاية حاصلة في موارد الشبهة المحصورة، ويدلّ على ذلك تفريع قولهعليهالسلام : « فتدعه من قبل نفسك » على ذلك، فانّه يظهر منه: أن كلّ ما يوجب
____________________
(١) الكافي: ج ٥ ص ٣١٣ ح ٣٩.
(٢) الكافي: ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠.
حصوله أن يترك الانسان ما كان مشتبهاً حكمه، ويدعه من قبل نفسه يكون غاية لهذا الحلّ، ولا ريب أنّ ثبوت العلم الاجمالي بعد إستقلال العقل بايجابه الاحتياط كالعلم التفصيلي بالحرمة.
ويؤيّد ذلك: الأمثلة المذكورة في ذيل الخبر، فانّ الغرض إمّا مجرّد التشبيه والتمثيل، وإمّا يكون من مجاري الاصول، وعلى أيّ تقدير هي داخلة في الشبهات البدوية، وليس فيها من موارد الشبهة المحصورة مثال، ولو كان موارد الشبهة يفيد الاذن فيها، كان التمثيل بها ألزم.
بل يمكن أن يقال: ان التمثيل شاهد على أنّ المراد من الشىء في قولهعليهالسلام : كل شيء، هو خصوص الشبهات البدوية، والفرق بين هذا وسابقه: أنّه على الأوّل كان أطراف الشبهة داخلة في قوله كل شيء، لكن عدم الحليّة فيها لأجل حصول الغاية، وأمّا على هذا الاحتمال لا يكون اصلاً داخلة في قولهعليهالسلام كل شيء ، وهذا أظهر.
مع امكان أن يقال: بعد تسليم انّ كل شيء عام يشمل كل مشتبه، وليس في قوله فتدعه دلالة على أنّ ذكر العلم بشخص الحرام في الغاية لأجل أنّه أحد أفراد الغاية، وليس في التمثيل أيضاً دلالة أو تأييد أنّ استقلال العقل بوجوب امتثال الخطاب المعلوم اجمالاً مانع عن حمل اللفظ على إرادة ما هو ظاهره، وليس في الخطاب بعد إقترانه بهذه القاعدة العقلية ظهور في إرادة معناه الحقيقي.
لا نقول: إنّ حكم العقل بوجوب الامتثال عند العلم الاجمالي حكم تنجيزي لا يمكن رفعه بخطاب الشرع كما هو ظاهر بعض المشايخ(١) ، بل نقول: وان كان حكم العقل بوجوب الامتثال معلّقاً على عدم رفع الشارع لتنجز الخطاب وجعل الاشتباه عذراً - كما سيجيء بيانه إن شاء اللّه - إلاّ أنّ إبداء المانع عن تنجّز الخطاب المعلوم اجمالاً بعد جريان ديدن العقلاء على الاحتياط فيه، وارتكاب ذلك في
____________________
(١) لعلّ مراده الشيخ الأنصاري، راجع فرائد الاصول: ص ٢٧.
الأذهان إلى أن بلغ حدّاً يدّعى امتناع إذن الشارع في المخالفة، ولزوم القبح عليه إن فعل ذلك، لا يليق أن يكون بمثل هذا الخطاب الذي يمكن الخدشة في ظهوره في ذلك من وجوه مرّ الاشارة اليها.
وبالجملة: كما يمكن أن يكون الخبر رافعاً لحكم العقل، لكونه معلّقاً على عدم إذن الشارع كذلك يمكن أن يكون حكم العقل رافعاً لظهور هذا الخبر في شموله مورد القاعدة، وذلك نظير ما قيل: من اجمال المجاز المشهور لاحتمال أن يكون المعنى الحقيقي مراداً إتكالاً على ظهوره واحتمال أن يكون المعنى المجازي مراداً اتكالاً على الاشتهار.
وبالجملة: إقتران اللفظ بما يمكن الاتكال عليه في إرادة خلاف ظاهره سبب لإجمال اللفظ وعدم ظهوره في المعنى الذي كان ظاهراً فيه لولا ذلك.
وأجاب بعض المحقّقين(١) عن دلالة الصحيحين: بأنّ هذه الأخبار كما تدلّ على حلّية كل واحد من المشتبهين، كذلك تدلّ على حرمة ذلك المعلوم اجمالاً، لأنّه ايضاً شيء علم حرمته.
وأورد على ذلك: بانّ غاية الحلّ معرفة الحرام بشخصه، ولم يتحقّق في المعلوم اجمالاً، ودفع.
أمّا في قولهعليهالسلام « كل شيء لك حلال حتى تعلم انّه حرام بعينه » فبانّه لا يدلّ على ما ذكر، لأنّ قولهعليهالسلام « بعينه » تأكيد للضمير، جيء به للاهتمام في اعتبار العلم ، كما في : رأيت زيداً بعينه، لدفع توهم [ وقوع الاشتباه في الرؤية ](٢) وإلاّ فكل شيء علم حرمته فقد علم حرمة نفسه، فاذا علم نجاسة إناء زيد وطهارة اناء عمر واشتبه الاناءان فاناء زيد شيء علم حرمته بعينه.
نعم يتّصف هذا المعلوم المعيّن بكونه لا بعينه، إذا اطلق عليه عنوان أحدهما
____________________
(١) هو الشيخ الأعظم -قدسسره - في الرسائل، عند البحث عن الشبهة المحصورة، ص ٤٠٤.
(٢) أثبتناه من المصدر.
فقال أحدهما لا بعينه في مقابل أحدهما المعيّن عند القائل.
وأمّا في قوله كل شيء فيه حلال وحرام بعد تسليم ظهوره فيما ذكر من أنّ الغاية معرفة الحرام بشخصه، حيث انّ قوله بعينه قيد للمعرفة، ومؤدّاه حينئذٍ معرفة الحرام بشخصه، وهي لا تتحقّق إلا عند إمكان الاشارة الحسيّة إلى الحرام فبأنّ إبقاء الصحيحة على هذا الظهور يوجب المنافاة لما دلّ على حرمة ذلك العنوان المشتبه، مثل قوله « اجتنب عن الخمر » لأنّ الاذن في كلا المشتبهين ينافي المنع عن عنوان مردّد بينهما، فالتمسّك بهذا الخبر يوجب الحكم بعدم حرمة الخمر المعلوم اجمالاً في متن الواقع، وهو ممّا يشهد الاتّفاق والنصّ على خلافه، حتى نفس هذه الأخبار حيث إنّ مؤدّاها ثبوت الحرمة الواقعية للأمر المشتبه.
أقول: أمّا ما ذكرت من دلالة الخبرين على حرمة ذلك الأمر المعلوم اجمالاً، فحاصله دعوى دلالة الخبر على المتناقضين ضرورة أنّ السلب الكلي ينافي الايجاب الجزئي.
ويرد عليه: أنّ الظاهر من الشيء في قوله: كل شيء هو الحقيقة المأخوذة في الخارج المعيّن عند المخاطب، وغاية الحلّية معرفة حرمة ذلك الموجود الخارجي وهي في مورد الشبهة ليست إلاّ الأطراف وليس خارجاً عن الأطراف موجود خارجي يكون مشمولاً للخبر، وذلك في الخبر الأوّل ظاهر، حيث إنّ قوله: بعينه من قيود المعرفة، وأمّا في الخبر الثاني فلظهور قوله حتى تعرف انّه حرام في ذلك، لرجوع الضمير إلى الشخص.
وبالجملة: معرفة حرمة الشخص وإن كان شاملاً لمعرفة حرمة الشيء بعنوان ينطبق عليه، وإن جهل الانطباق عند من يعرف حكم العنوان، لأنّه يصدق على معرفة حرمة إناء زيد - الذي جهل شخصه - معرفة حرمة ذلك الشخص، إلاّ أنّ الظاهر من معرفة حرمة الشخص عرفاً معرفة أنّه حرام من حيث إنّه شخص خارجي.
والحاصل: أنّ غاية الحلّية في الخبر إن كانت معرفة الحرام بشخصه كما هو
الظاهر، فلا دلالة فيه على حرمة معرفة العنوان المشتبه، وإن كانت معرفة الحرمة ولو إجمالاً دلّت على حرمة المخالفة القطعيّة، إذ المفروض حصول العلم بحرمة أحدهما لا بعينه، بل على وجوب الموافقة القطعية، لأنّ جعل معرفة الحرام اجمالاً غاية للحلية الظاهريّة يدلّ على عدم معذورية الجاهل بالحرمة من جهة الجهل باتّحاد المشكوك في حرمته مع العنوان المعلوم حرمته، والاّ لغى جعل العلم الاجمالي غاية، اذ هو لا ينفكّ عن الجهل من هذه الجهة.
وبالجملة: لا دلالة في الخبر على الاذن في المشتبهين والمنع عن المعلوم الاجمالي معاً، لأنّ الموجود الخارجي منحصر في المشتبهين، وعموم الشيء انّما هو الموجودات الخارجية المشتبهة بها، بل إمّا يدلّ على الأوّل، وإمّا يدلّ على الثاني، فان ثبت ظهوره في أحدهما فهو، والاّ فهو مجمل.
ومن هنا ظهر: أنّ منع كون الغاية معرفة شخص الحرام بظاهر الخبر، لأجل أنّ بعينه تأكيد لا قيد لا وجه له،
إذ قد عرفت أنّه يمكن دعوى الظهور في ذلك بعد تسليم كون قوله بعينه تأكيداً - كما هو الظاهر - ولا أظنّ ان من ادّعى الظهور ايضاً استند في دعواه إلى أنّ قوله بعينه بمعنى بشخصه، ويكون قيداً للمعرفة، حيث انّه ظاهر الفساد، إذ كونه قيداً للمعرفة يفيد أنّ غاية الحلّية معرفة شخص الحرام، لأنّها تنقسم إلى معرفة الشخص، وإلى معرفة النوع بملاحظة كون المعروف نوعاً أو شخصاً كما هو واضح، والمعروف في الخبر هو حرمة الشيء التي تأولت إليها الجملة الواقعة بعد تعرف المبدوءة بان المؤوّلة ما بعدها إلى المصدر، ولا ريب أنّ معرفة الحرمة لا يكون منقسمة بقسمين معرفة بشخص الحرمة ومعرفة بنوعها حتى يصح تقييدها بأحدهما، مع انه لا يقيد مع ذلك ما قصد من كون الغاية معرفة شخص الحرام.
إلاّ أن يقال: إنّ معرفة شخص الحرمة اريد منها معرفة شخص الحرام تجوّزاً ولا يخفى ما فيه.
وأمّا ما ذكر من أن إبقاء الصحيحة الى اخره، أنّ مخالفة الحكم الظاهري للحكم الواقعي لا يوجب ارتفاع الواقعي، كما في الشبهة المجرّدة عن العلم الاجمالي،
مثلاً قول الشارع اجتنب عن الخمر شامل للخمر الواقعي الذي لم يعلم به المكلّف ولو اجمالاً، وحلّيته في الظاهر، كما هو قضيّة أدلّة البراءة لا يوجب خروجه عن العموم المذكور حتى لا يكون حراماً واقعياً، وحينئذٍ فلا محذور في التزام مثل ذلك في الخمر المجهول شخصه المعلوم وجوده بين الاطراف اجمالاً.
وأمّا ما يقال: من أنّ الحكم الظاهري لا يقدح مخالفة للحكم الواقعي في نظر الحاكم مع جهل المحكوم بالمخالفة، لرجوع ذلك إمّا إلى معذورية الجاهل - كما في أصالة البراءة - أو إلى بدلية الحكم الظاهري عن الواقع، أو كونه طريقاً إليه على الوجهين في الطرق الظاهرية المجعولة، وأمّا مع علم المحكوم بالمخالفة فيقبح من الجاعل جعل كلا الحكمين، لأنّ العلم بالتحريم يقتضي وجوب الامتثال بالاجتناب عن ذلك المحرّم، فاذن الشارع في فعله ينافي حكم العقل بوجوب الطاعة.
ففيه: أنّ معذورية المحكوم قد يكون بنفسه، وقد يكون بجعل الحاكم، وفي موارد الشبهة لو دلّ دليل على الاذن في إرتكاب كلا المشتبهين كان راجعاً إلى أنّ الجهل بشخص الحرام على وجه يمتاز عن غيره عند المحكوم عذر له في ارتكاب الحرام، وأمّا قبح جعل ذلك من الحاكم لأجل منافاة ذلك لحكم العقل، فهو مبني على أن يكون العلم الاجمالي علّة لتنجّز الخطاب عند العقل وهو ممنوع.
بل نقول: إنّ الذي يحكم به العقل هو أنّ العالم اجمالاً ما لم يجعل جهله عذراً له لا يأمن من العقاب إذا خالف الخطاب المعلوم اجمالاً، فانّه لا يمتنع عند العقل أن يكون الخطاب معلوماً عند المحكوم، ومع ذلك لا يكون الطلب فعلياً على وجه يترتّب على مخالفته العقاب، بل يجوز أن يجعل الشارع عذراً للمكلّف وبسببه لا يريد منه موافقة ذلك الخطاب المعلوم.
نعم يحكم بوجوب الموافقة ما لم يعلم من الشارع إذن، لأنّ العلم بالخطاب مسقط للعذر من قبل المكلّف في نفسه وكون جهله بالتفصيل عذراً، مبني على الجعل والمفروض عدم حصوله، وقياس العلم الاجمالي على العلم التفصيلي بعد إمكان
جعل العذر في الأوّل لكون المكلّف به مجهولاً ببعض الاعتبارات لا وجه له.
بل نقول: لو فرض امكان جعل العذر في موارد العلم بالحكم تفصيلاً لوجود ما يصلح ان يجعل عذراً نظير الجهل بالتفصيل في موارد العلم الاجمالي لحكمنا هناك ايضاً بجواز الاذن في المخالفة.
والحاصل: أنّ الاجمالي ليس كالتفصيلي في كونه علّة تامّة لوجوب موافقة ذلك الحكم عند العقل، حتى ينافي الاذن في المخالفة لذلك الحكم القطعي فيقبح جعله، بل هو علّة لحكم معلق على غاية ذلك الحكم باذن الشارع في المخالفة، فحكم العقل والاذن في المخالفة من الشارع لا تعارض بينهما، بل الاذن وارد على حكم العقل، كورود دليل الحرمة على أصالة البراءة.
وممّا يؤيد ما ذكرنا: أنّ الاذن في المخالفة الاحتمالية للخطاب حاصل في بعض المقامات اتّفاقاً، كالاذن بالوضوء بماء مستصحب الطهارة مع التمكّن من الوضوء بالماء المتيقّن طهارته، وجائز في المقام بتسليم المحقق المذكور -رحمهالله - فانّه صرّح بجواز الاذن في مقام الامتثال بالاكتفاء ببعض الاطراف - في مواضع من كلامه -(١) مع أنّ العلم الاجمالي لو كان منجّزاً للخطاب المعلوم وحكم العقل عنده بوجوب الاطاعة من غير تعليق على شيء وجب المنع عن ذلك ايضاً، لأنّ الذي يحكم به العقل هو الاطاعة اليقينية عند التمكّن منه، ومخالفة حكمه يحصل بمجرّد الاذن بالاكتفاء ببعض الاطراف فلو كانت قبيحة لكان ذلك ايضاً قبيحاً.
ودعوى: أنّ تجويز الوضوء بالماء المستصحب طهارته والاكتفاء ببعض الاطراف على تقدير الاذن به - كما إذا قام طريق ظنّي ثابت الحجيّة على أن بعض الاطراف هو المعلوم بالاجمال - انّما هو لأجل أنّ الوضوء بمستصحب الطهارة بدل عن الطهارة اليقينية وما حكم الطريق بأنّه المعلوم بالاجمال بدل عمّا وجب الاجتناب.
لا تدفع الاشكال، إذ لا يرفع بوجود الاستصحاب والطريق الشك الموجب
____________________
(١) الرسائل: ص ٤٠٦ و.
لاجمال العلم، وحينئذٍ فأي فرق بين الاذن في المخالفة الاحتمالية بجعل البدل، والاذن في المخالفة القطعية بجعل شيء عذراً.
نعم فرق بين المقامين من حيث إنّ الاذن في المخالفة الاحتمالية هناك خفيّ، ويكون من لوازم الأمر بالعمل بالاستصحاب والعمل بالطريق، وهنا ليس كذلك وهذا الخفاء بعد اطلاع العبد على حقيقة الأمر لا يرفع به القبيح لو كان بنفسه.
والحاصل: أنّ العقل كما يحكم بحرمة المخالفة القطعيّة، كذلك يحكم بوجوب الموافقة القطعية والموجب بحكمه في المقامين ليس الاّ العلم الاجمالي بالخطاب والتمكّن من الاحتياط، فعلى من يدّعي الفرق بين المقامين، ويجوّز مخالفة حكمه في المقام الثاني، ويمنع عنها في الأوّل إبداء الفرق بين المقامين فتأمّل.
ثم انّه يظهر ممّا ذكرناه في الخبرين السابقين: ما في الاستدلال على جواز المخالفة القطعية بمثل قولهعليهالسلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي او أمر(١) . وقولهعليهالسلام الناس في سعة ما لم يعلموا(٢) ، لأنّه لم يرد في اطراف الشبهة نهي ولا أمر ولا يعلم حرمتها فانّ الظاهر أنّ كلّ شيء يراد به المشكوك حكمه من حيث نفسه مع قطع النظر عن وجود العلم الاجمالي، وأمّا قولهعليهالسلام : الناس الى آخره، فعدم دلالته على المدّعى ظاهر، سواء قرئ بالاضافة أم لا، فانّ العلم المأخوذ فيه أعم من التفصيلي والاجمالي. وملخّص معنى الحديث: أنّ الناس في سعة تكليف لا يعلمونه اجمالاً أو هم في السعة ما دام لا يكونون عالمين بشيء لا اجمالاً، ولا تفصيلاً بل نقول: يمكن الاستدلال بمفهوم هذا الخبر على تقدير كون « ما » زمانية على وجوب الاجتناب عن اطراف الشبهة بأن منطوقه ان الناس ما دام لا يكونون عالمين بشيء لا اجمالاً ولا تفصيلاً، ولا عموماً ولا خصوصاً، يكونون في السعة، ومفهومه حينئذٍ انهم اذا علموا بأحد من الوجوه المذكورة يكونون في الضيق. فهذا الخبر على
____________________
(١) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٣٧ ليس فيه: « أو أمر » وجامع الأحاديث ج ١ ص ٣٢٨ ح ٦١٤.
(٢) المحاسن: ص ٤٥٢ ح ٣٦٥.
تقدير دلالة تلك الأخبار السابقة على الاذن في المخالفة القطعية معارض لها.
ويمكن مساعدة هذا الخبر في مقام الترجيح من حيث كونه أحوط وموافقاً للمشهور.
إلاّ أن يقال: إنّ معنى الحديث أنّ الناس في سعة ما لم يعلموا التكليف الفعلي وهم متحيّرون، مفهومه حينئذٍ انّهم اذا علموا التكليف الفعلي فهم ليسوا في السعة، ولا ريب انه اذا ثبت بالدليل الشرعي أنّ الحكم المعلوم بالاجمال لا يكون منجّزاً وانما ينجّز بعد العلم بالتفصيل، فعلم أنّ الحكم المعلوم بالاجمال لا يكون فعليّاً فلم يحصل العلم بالتكليف الفعلي الذي أوجب معه الاحتياط مفهوم تلك الرواية فتأمّل.
وممّا يستدلّ به أيضاً على الاذن مع الجهل بشخص الحرام: رواية حنّان بن سدير انه قال: سئل أبو عبد اللّهعليهالسلام وأنا حاضر عن جدي يرضع من خنزيرة حتى كبر واشتدّ عظمه ثمّ انّ رجلاً استفحله في غنمه فأخرج له نسل، فقالعليهالسلام : أمّا ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنّه، وأمّا ما لم تعرفه فكله، فهو بمنزلة الجبن ولا تسأل عنه(١) .
وفي خبر بشر عن أبي الحسن الرضاعليهالسلام في جدي يرضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم فقال: هو بمنزلة الجبن فما عرفت أنّه من خنزيرة فلا تأكله وما لم تعرفه فكله(٢) .
فانّهما باطلاقهما يدلاّن على أن كلّ ما لم يعلم حرمته - وإن علم إجمالاً حرمة أحد الأمرين اللذين هو أحدهما - يكون حلالاً، ويكون جائز الأكل.
والجواب عنهما: بأنّ الظاهر منهما الاذن في المشتبه عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فانّ قولهعليهالسلام « أمّا ما عرفت من نسله » وقولهعليهالسلام « فما عرفت انه من خنزيرة » في الخبر الأخير يقتضي وجود حرام معروف، ويكون الشك
____________________
(١) الكافي: ج ٦ ص ٢٤٩ ح ١ مع اختلاف فيه.
(٢) الكافي: ج ٦ ص ٢٥٠ ح ٢ مع اختلاف فيه.
في حرمة غيره حينئذٍ يكون شكّاً في الزائد، ولا ريب أنّ الأصل حينئذٍ البراءة.
ويمكن الاستدلال أيضاً بأخبار اخر أيضاً يأتي ذكرها والجواب عنها.
المقام الثاني
في وجوب الموافقة القطعية
والحق فيه: الوجوب وفاقا للمشهور كما قيل، وعن المدارك: أنّه مقطوع به في كلام الاصحاب(١) وفي فوائد الاستاذ الاكبر نسبه الى الاصحاب(٢) وعن شرح وافية الكاظميني دعوى الاجماع صريحاً(٣) وعن بعض في ذهابه الى القرعة(٤) .
لنا: ما مرّ من أن خطاب الشارع بالاجتناب عن الحرام الموجود بين المشتبهين معلوم، إذ المفروض العلم بحرمة نوعه والعلم بتحققه بين المشتبهين وحينئذٍ يجب عند العقل الاحتراز عن كلا المشتبهين تحصيلاً لفراغ الذمّة عن الخطاب المعلوم اشتغال الذمة به قطعاً.
وبالجملة: العقل ما دام لم يثبت من الشارع اذن في ترك الاحتياط في بعض الاطراف لا يحكم بالأمن من العقاب عند عدم التحرّز من بعض الاطراف على تقدير مصادفة الحرام معه في الواقع، فعلى من يدّعي الجواز بيان الاذن من الشارع في ترك الاحتياط.
احتج من جوّز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام بوجهين:
الأوّل: الأخبار الدالّة على جواز تناول الشبهة المحصورة، وانّما منع من تناول مقدار الحرام، للجمع بين هذه الأخبار، وما بين ما دلّ على أنّ العنوان الواقعي حرام،بأنّ الشارع جعل بعض المحتملات بدلاً عن الحرام الواقعي، فيكفي ترك ذلك في
____________________
(١) مدارك الأحكام: ج ١ ص ١٠٧، تحقيق مؤسسة آل البيت.
(٢) الفوائد الحائرية: الفائدة الرابعة والعشرون. ط الحجرية.
(٣) لا يوجد عندنا كتابه.
(٤) حكى ذلك الشيخ الانصاري في فرائده: ص ٤٠٩.
مقام الامتثال، كما يكفي الصلاة إلى بعض الجهات في الامتثال، إذا رخّص الشارع في ترك الصلاة إلى بعض الجهات، واكتفي بالصلاة إلى بعضها، وهذه الأخبار كثيرة منها: موثقة سماعة عن الصادقعليهالسلام : عن رجل أصاب مالاً من عمّال بني امية وهو يتصدّق منه، ويصل قرابته، ويحجّ ليغفر له ما اكتسب، ويقول: إنّ الحسنات يذهبن السيئات، فقالعليهالسلام : ان الخطيئة لا تكفّر الخطيئة، وإنّ الحسنة تحطّ الخطيئة ثم قال: إن كان خلط الحرام حلالاً فاختلطا جميعاً فلم يعرف الحلال من الحرام فلا بأس(١) .
فانّ ظاهره نفي البأس عن التصدّق وصلة القرابة والحج وانه يحصل له الأجر في ذلك على تقدير خلط الحرام بالحلال وهذه إمّا إذن في مخالفة الاحتياط في جميع الأطراف بناءً على أنّ امساك الباقي أيضاً يظهر جوازه منه، أو إذن في مخالفة بعض الأطراف، وعلى أيّ تقدير يثبت المطلوب وهو جواز تناول مقدار ما عدا الحرام.
الثاني: الأخبار السابقة الدالّة على أنّ ما لم يعلم حرمته يكون حلالاً(٢) . وهي وإن كانت بظاهرها تقتضي الاذن في الجميع، إلاّ أنّه منع من إرتكاب مقدار الحرام، إمّا لأنّه مستلزم للعلم بارتكاب الحرام وهو حرام، وإمّا لما ذكره بعضهم على ما حكي من أن ارتكاب مجموع المشتبهين حرام لاشتماله على الحرام.
بيان ذلك: أنّ ما أذن فيه الشارع هو استعمال ما لم يعلم حرمته، ومجموع الأطراف لعلمنا بأنّ فيه حراماً حرام، ولو باعتبار ذلك الجزء الحرام المعلوم وجوده فيه، وكذلك كل واحد من الأطراف بشرط الاجتماع مع الآخر حرام، لأنّه معلوم الحرمة ولو باعتبار ما اجتمع معه كل واحد منهما بنفسه مع قطع النظر عن الآخر مجهول الحرمة فيكون حلالاً.
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب ٥٢ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ٩ ج ٨ ص ١٠٤. وب ٤ من أبواب ما يكتسب به ح ٢ ج ١٢ ص ٥٩ مع اختلاف فيه.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٣٧ والمحاسن: ص ٤٥٢ ح ٣٦٥.
والجواب أمّا عن الثاني: فبأنّ الأخبار المذكورة قد عرفت أنّها لا تدلّ على جواز شيء من أطراف الشبهة، لأنّها مختصة بالشبهات الغير المقرونة بالعلم الاجمالي، ولو سلّمنا شمولهما للاطراف، فلا وجه لاختصاص الترخيص ببعض الاطراف، وما ذكر من المانع لا يفيد ذلك.
أمّا الأوّل منه وهو ان العلم بالحرام تحصيله حرام.
ففيه: أنّ ذلك مسلّم إذا قصد به التجسّس عن حال الغير، وامّا تحصيل الانسان القطع بانّه صدر منه الحرام فلا نسلّم حرمته، وأيّ دليل دلّ على تحريمه، هذا كلّه إن حمل على ظاهره.
وإن اريد من ذلك: أنّ مخالفة إذا كانت معلومة حرام، وإذا كانت احتمالية فليست بحرام.
ففيه: انّه لا فرق عند العقل بين المخالفة القطعية والاحتمالية، وكما يحكم في الأوّل بالحرمة، كذلك يحكم بها في الثاني سواء كان مناط حكمه في ذلك حسن الاطاعة وقبح المخالفة أم كان مناط حكمه حصول الفرار من الضرر المترتّب على المخالفة بتركها، إذ العقل كما يحكم بأنّ الفرار من الضرر المقطوع لازم، كذلك يحكم بأنّ الفرار من الضرر المحتمل لازم.
والحاصل: ان الفعل ما لم يقطع بعدم ترتّب الضرر عليه لا يرخّص العقل فيه، وموارد إذنه المخالفة إنّما هو للأمن من الضرر، لأجل قيام دليل على أن لا يترتّب الضرر على الفعل على تقدير كونه مخالفاً، ومجرّد عدم القطع لعدم كونه مخالفة، لا يوجب الاذن فيه من العقل، مع أنّه إن قصد من قوله انّ المخالفة اذا كانت معلومة حرام أنّ المخالفة المعلومة من حيث المخالفة حرام، ففيه: أنّ ذلك ينتج جواز إرتكاب الجميع، فجعله مقدّمة للمنع عن مقدار الحرام، لا وجه له، وإن قصد أنّ المخالفة التي يتعلّق بها العلم ولو بعدها حرام، ففيه: أن هذا راجع إلى ما سبق جوابه: من أنّ تحصيل العلم بارتكاب الحرام حرام.
وأمّا الوجه الثاني: وهو أن ارتكاب مجموع المشتبهين حرام، ففيه: أنّ الحرام هو
أحدهما المعيّن في الواقع المردّد بين الطرفين عند المكلّف، ومجموع الأطراف اتّصافه بالحرمة انّما هو لكون الواحد المردّد الذي بينهما حرام، وحينئذٍ فضمّ ما عدا الحرام بالحرام والحكم على المجموع بالحرمة لا وجه له إلاّ باعتبار كون الجمع بينهما موجباً لحصول العلم بالحرام، وقد عرفت أنّ تحصيله ليس بحرام.
ومن ذلك يظهر: أنّه لا وجه لقوله: وكذلك كل واحد بشرط الاجتماع مع الآخر، وذلك: لأنّ حرمة كل واحد بشرط الاجتماع، لكون المجموع مشتملاً على الحرام يقيناً، وإلاّ فالحكم على المعيّن بالحرمة ولو بشرط الاجتماع، ليس له وجه، لجواز أن يكون الحرام الفرد الآخر الذي جعل اجتماعه مع هذا الفرد من شرائط حرمة ذلك، وحينئذٍ فلو فرضنا أن تحصيل العلم بالحرام ليس بحرام، لا يمكن وجه للحكم بأنّ كل واحد بشرط الانضمام حرام، ليتوصّل به الى المنع عن مقدار الحرام.
وأمّا عن الأوّل: فيرد عليه (أوّلاً): انّ أخبار الحلّ ليست في مرتبة الأدلّة الدالّة على حرمة العنوان الواقعي حتى يقع بينهما تعارض، لأنّ الاباحة الظاهرية لا تنافي الحرمة في الواقع وامّا دعوى قبح جعل الاباحة الظاهرية - مع علم المكلّف بوجود الحرام -، فقد عرفت المناقشة فيها، وأنّه لا فرق بين الاذن في المخالفة القطعية - كما في ما نحن فيه - وبين الاذن في المخالفة الاحتمالية - كالاذن بالتطهير بماء مستصحب الطهارة مع وجود معلومها - فالجمع بين الأدلّة والتصرّف في بعضها وصرفها عن ظاهرها بدون التعارض لا وجه له، وقد عرفت أنّه لا تعارض بين الأدلّة.
نعم يعارض هذه الأخبار ما دلّ من الأخبار الخاصة الدالّة على وجوب الاجتناب في موارد خاصة المستشمّ منها أنّ الحكم بوجوب الاجتناب لأجل كون الموارد مندرجة تحت عنوان حكمه وجوب الاجتناب، ولابدّ حينئذٍ من ملاحظة الأخبار من حيث التكافؤ وإمكان الجمع، فان كانت متكافئة وامكن الجمع، وإلاّ وجب الطرح والرجوع الى حكم العقل - كما سيأتي -.
(وثانياً): أنّ ما يدّعى دلالته على الترخيص في موارد الشبهة فقد مرّ الكلام في
دلالة بعضها وأنّه لا دلالة فيه، وأمّا قولهعليهالسلام في موثقة سماعة: إن كان خلط الحرام حلالاً فاختلط جميعاً فلم يعرف الحلال من الحرام فلا بأس، فيحتمل أن يكون المقصود حصول الخلط عند من أصاب منه المال، وحينئذٍ يكون وجه عدم البأس بما ذكر، لأجل وجوب حمل هذه على ظاهرها الذي هو الملكية، وأمّا ما ورد في جواب السؤال عن جواز شراء السرقة أمّا السرقة فلا، إلاّ اذا اختلط مع غيره فلا بأس إذا لم تعرف السرقة بعينها، إلاّ أن يكون من مال السلطان، فان حمل الاستثناء فيه على الاتّصال فيكون معناه أنّه يجوز شراء السرقة مع الخلط إذا لم يعرف السرقة بعينها ومعناه أن شراء السرقة مع الجهل بكونه شراء السرقة لعدم معرفة السرقة لا بأس به، والقول: بأنّ شراء السرقة قد يكون مع جميع أطراف الشبهة، وقد يكون وحدها مع الجهل بكونها كذلك، والذي يقتضيه الحديث باطلاقه جواز شرائها في الصورتين مدفوع: بأنّ المقصود من الخبر التفصيل بين العلم بكون شراء السرقة وبين صورة الجهل بذلك لأجل أنّ المشتري لا يعلم كونها سرقة، بالجواز في الثاني، والحرمة في الأوّل، كما لا يخفى على من تدبّرها والفرض الذي ذكر في صورة شراء السرقة مع الجهل بشخصها مستلزم للعلم بشراء السرقة بعينها وإن جهل شخصه.
والحاصل: أنّ قوله: « أمّا السرقة فلا » يدلّ على أنّ شراء السرقة مطلقا ولو في ضمن امور يعلم أنّ أحدها سرقة ليس بحلال، وقولهعليهالسلام : « الاّ إذا اختلط إلى آخره »، معناه: أنّ شراء السرقة في الواقع إذا اختلط مع غيره خلطاً يوجب الجهل بكون الشراء شراء سرقة فلا بأس به، وحمله على الأعم من شراء وحده وشرائه مع غيره، مع أنّه مخالف للظاهر، لأنّ الظاهر كون السرقة هو المشترى مستقلاً مناف لاطلاق قوله: أمّا السرقة فلا، فانّه كما عرفت يقتضي المنع عن شراء السرقة ولو في ضمن امور يعلم بأنّ احدها سرقة كما لا يخفى.
وبالجملة: الظاهر المنساق من الرواية: فارق بين شراء محتمل السرقة مستقلاً وبين شراء السرقة قطعاً فلا ربط له بما نحن فيه والحاصل: انّ هذه الأخبار مع كثرتها
ليس فيها ما يكون صريحاً في الدلالة على جواز تناول اطراف الشبهة بعضاً أو كلاًّ فالبعض الظاهر منها في ذلك ايضاً بعد ملاحظة ارتكاب الاحتياط في الأذهان لا يبقى له ظهور في ذلك.
وقد يستدلّ لوجوب الموافقة القطعية ببعض الأخبار: كقولهعليهالسلام : ما اجتمع الحلال والحرام إلاّ غلب الحرام الحلال(١) ، وقولهعليهالسلام : اتركوا ما لا بأس به حذراً عمّا به البأس،(٢) وقولهعليهالسلام في الجواب عن الجبن والسمن في ارض المشركين : أمّا ما علمت أنّه قد خلطه الحرام فلا تأكل، وما لم تعلم فكل(٣) . فانّ الخلط يصدق مع الاشتباه. وقولهعليهالسلام في رواية ابن سنان: كل شيء حلال حتى يجيئك شاهدان أنّ فيه الميتة(٤) . و قولهعليهالسلام في حديث التثليث: وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم(٥) . بناء على أنّ المراد من الهلاكة ما هو أثر للحرام، فإن كان الحرام لم يتنجّز التكليف به فالهلاك المترتّب عليه منقصة ذاتية، وإن كان ممّا تنجّز التكليف به - كما فيما نحن فيه - كان المترتّب عليه هو العقاب الاخروي، وحيث إنّ رفع العقاب المحتمل واجب بحكم العقل، وجب الاحتياط عن كل مشتبه بالشبهة المحصورة، ولمّا كان دفع الضرر غير العقاب غير لازم اجماعاً كان الاجتناب في الشبهة المجرّدة مستحب والجواب أمّا عن قوله: ما اجتمع الحلال فانّ الاشتباه غير الاجتماع فإنّ الظاهر أنّ المراد من الاجتماع هو الاختلاط. ومنه يظهر الجواب عن قوله: أمّا ما عرفت أنّه قد خلطه الحرام، فانّ صدق الخلط على الاشتباه محلّ منع، مع أنّا لو سلّمنا أنّه أعمّ من الاشتباه والامتزاج، نقول: إنّ المراد من الخلط هنا هو الامتزاج بملاحظة أنّ
____________________
(١) عوالي اللئالي: ج ٢ ص ١٣٢ ح ٣٥٨.
(٢) سنن ابن ماجة: ج ٢ ص ١٤٠٩ ح ٤٢١٥.
(٣) التهذيب: ج ٩ ص ٧٩ ح ٧١ مع اختلاف فيه.
(٤) وسائل الشيعة: ب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ٩١.
(٥) الكافي: ج ١ ص ٦٧ قطعة من الحديث ١٠.
ما الموصولة هنا كناية عن الجبن والسمن في أرض المشركين، والظاهر من قولنا: اجتنب عن سمن خلطه الحرام ان المراد من الخلط هو الامتزاج فظهر: أنّ قولهعليهالسلام امّا ما عرفت انه قد خلطه الحرام الى آخره بمنزلة قولهعليهالسلام اما ما عرفت إنه حرام بعينه في خبر الجدي السابق ذكره، بل يمكن الاستدلال بذيل الخبر: على جواز تناول الشبهة لاطلاق قولهعليهالسلام : وما لم تعلم فكل، فانّه يعمّ ما لو اقترن بغير المعلوم علم إجمالي، وما لو لم يقترن، وإن كان الجواب عنه يظهر ممّا أسلفناه سابقاً: من أنّ مثله مسوق لبيان حكم الشبهات البدوية وما يجري مجراه.
وأمّا قولهعليهالسلام : اتركوا ما لا بأس به حذراً عمّا به البأس، فالظاهر أنّه نظير قولهعليهالسلام في خبر التثليث: من رعى غنمه قرب الحمى نازعه نفسه إلى أن يرعيها في الحمى، ألا ولكل ملك حمى، ألا وإنّ حمى اللّه محارمه، فاتّقوا حمى اللّه ومحارمه(١) الى آخره، في أنّ المراد منه: مجرّد إرشاد وبيان: أنّ النفس اذا تعوّدت بارتكاب الشبهات يهون عنده الأمر في ارتكاب المحرّمات، ويغلب عليه الهوى فلا يهاب ما يترتّب عليها من المفاسد والمؤاخذة.
وأمّا قولهعليهالسلام : كل شيء حلال حتى يجيئك شاهدان، فالظاهران المراد من الشيء: هو الفرد وكون المجموع شيئاً واحداً اعتباري بل هو حقيقة أشياء فشموله له خلاف الظاهر، مع أنّه لا ريب في أنّ كل واحد من أجزاء المجموع شيء، فيقع التعارض في مدلول الحديث لحكمه على المجموع بالحرمة وعلى كل جزء بالحل.
وأيضاً نقول: حرمة المجموع ينافيه حلّية الجميع، ولا ينافيه حرمة البعض وحليّة البعض، فلو دلّ خبر على أنّ بعض الاطراف يجوز ارتكابه، ويكون الطرف الآخر بدلاً عن الحرام لم يكن بينه وبين هذا الخبر منافاة.
وأمّا خبر التثليث: فدلالته على وجوب الاجتناب انّما هو بعد إحراز تنجّز التكليف من الخارج، ومعه لا حاجة إليه، إذ مع العلم بالتنجّز يحصل العلم بترتّب
____________________
(١) وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ١٢٤، ب ١٢ من أبواب صفات القاضي، ح ٤٧.
العقاب على المخالفة، وبعد ضمّ الكبرى المذكورة - وهو أنّ دفع الضرر المحتمل واجب - ينتج وجوب الاجتناب.
وأمّا القول بأنّ المقصود من الاستدلال معارضة ما دلّ على ذلك لو وجد في الأخبار: فهو يرفع الصغرى المقصود اثباته من هذا الخبر، لأنّه كاشف عن عدم تنجّز التكليف بالمعلوم بالاجمال على أيّ تقدير أي على تقدير كونه في كل واحد من الطرفين، وحينئذٍ فلا يثبت بخبر التثليث احتمال ترتّب العقاب على ما اختار ارتكابه من الأطراف، إذ المفروض القطع بعدم العقاب لما دلّ على الترخيص كما لا يخفى.
وقد يستدلّ أيضاً لوجوب الاحتياط: بالأخبار الخاصة - بناءً على أنّه يستفاد من المجموع أنّ هذا الحكم ليس لخصوصية في الموارد، بل انّما هو لأجل أنّ الشأن في كل شبهة محصورة هو ذلك، وأنّ ذلك أمر مفروغ عنه بين الائمةعليهمالسلام وكذلك الشيعة والعامة - فمنها ما ورد في المائين المشتبهين: وهنا فائدة لابدّ من ذكرها - : وإن لم يكن مربوطاً بالمقام - وهي أنّه قد يقال : انّه يمكن التطهير بالمائين المعلوم وجود النجس في أحدهما بأن يتوضّأ بأحدهما ثم يطهّر بالآخر ما لاقى الماء الأوّل ثم يتوضّأ منه، فانّه حينئذٍ يكون بحكم الاصل أعني اصالة الطهارة في كلما شك في نجاسته متطهّراً عن الخبث ومتطهّراً عن الحدث يقيناً.
وقد يقال: إنّه يجب البناء حينئذٍ على ضدّ الحالة السابقة، لأنّ ما وصل إليه الماء إن كان نجساً قبل ذلك، يكون إرتفاع تلك النجاسة معلوماً والشك في حدوث نجاسة اخرى، لجواز أن يكون الماء الأوّل هو الماء النجس، وإن كانت طاهراً قبل ذلك يكون ارتفاع تلك الطهارة معلوماً بوصول الماء النجس والشك في زوال تلك النجاسة المتيقّنة.
والحاصل: أنّ الاستصحاب فيما إذا كان الطهارة هي الحالة السابقة رافعة لاصالة الطهارة فهو حينئذٍ لا يكون متطهراً عن الخبث ظاهراً.
والجواب: أنّ لنا أن نستصحب الطهارة الموجودة حال ورود الماء الطاهر،
والنجاسة حال ورود النجاسة، وحينئذٍ يكون كل واحد من الاستصحابين متعارضين، وليس لنا يقين بارتفاع أحد الحالتين المفروضتين، وانّما المتيقّن هو ارتفاع الحالة السابقة على ورود المائين، ونحن لا نريد من استصحاب الطهارة أو النجاسة، إستصحاب تلك الحالة المفروضة حتى يقال: إنّها منتفية الارتفاع، وحينئذٍ يرجع إلى أصل الطهارة، فيكون مستعمل هذا الماء متطهّراً عن الحدث والخبث، والظاهر أنّ مورد الأخبار الدالّة على وجوب الاجتناب ليس ما يمكن فيه الاحتياط بمثل هذا الجمع.
ومنها ما ورد في الصلاة في الثوبين المشتبهين: فانّه لو كان بعض الاطراف أو كلّها مع وجود هذا العلم الاجمالي بحكم الطاهر ظاهراً، لم يكن وجه للحكم بالاحتياط والجمع بين الصلاتين.
ومنها ما ورد في وجوب غسل الثوب من الناحية التى يعلم باصابة بعضها للنجاسة معلّلاً فيه: بقوله حتى تكون على يقين من طهارته(١) . فانّ وجوب تحصيل اليقين بالطهارة - على ما يستفاد من التعليل - يدلّ على أنّ أصالة الطهارة لا يكون جارية بعد العلم الاجمالي. إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة على الحكم بنفسها، أو بضميمة حكم العقل بعد صرف الروايات الدالّة على الحلّ - على تقدير شمولها لمورد الشبهة ظاهراً - عن ظاهرها بمعونة حكم العقل بناءً على ما سبق من أنّ اقترانه يكون [ مانعا: ط ] عن ظهور الخطاب في شموله لمورد الحكم الاجمالي.
تنبيهات
الأوّل: انّ وجوب الاحتياط انّما يحكم به العقل ويستقلّ به حيث كان حدوث التكليف بأمر مردّد بين المشتبهين معلوماً، فلو لم يكن ذلك معلوماً لا يجب الاجتناب، فلو علم بوقوع قطرة من البول بين أحد الانائين اللذين أحدهما كراً
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب النجاسات ح ٢ ج ٢ ص ١٠٠٦.
معلوم النجاسة تفصيلاً أو أحدهما خارج عن تحت ما يتمكّن المكلّف من استعماله لم يجب الاجتناب عن الاناء الآخر الذي ليس بكر، أو ليس بمعلوم النجاسة تفصيلاً، أو يكون ممّا يمكن استعماله والسّر في ذلك: إنّ وجوب الاحتياط انّما يكون ثابتاً لكونه طريقاً للامتثال اليقيني للتكليف المعلوم ثبوته بسب العلم الاجمالي بوجود الموضوع المحرّم بين الأطراف فحيث انتفى العلم بالتكليف ينتفي لازمه وهو وجوب الاحتياط. وهذا الكلام مطرد في جميع المواضع التي تكون في بعض الأطراف خصوصية لا يحصل القطع معها بثبوت تكليف بالاجتناب عن موضوع - معلوم التحقّق بين الاطراف - مجهول شخصه ومن هذا الباب ما لو كان بعض الأطراف خارجاً عن ابتلاء المكلّف. والمراد بخروجه عن الابتلاء: أن يكون بحيث لا يصحّ أن يكلّف بالاجتناب عنه منجّزاً من غير تعليق بشيء مثل التملّك، والاستعارة، أو غير ذلك، فانّ بعض الأطراف اذا لم يكن تعلّق التكليف الفعلي به حسناً لو كان حراماً، لا يكون التكليف بالموضوع المحرّم وجوده بين الأطراف معلوماً، لاحتمال أن يكون متّحداً مع ما خرج عن مورد إبتلائه، وحينئذٍ فلا موجب للاحتياط فيما يكون المكلّف مبتلى به من الأطراف، لأن وجوب الاحتياط انّما حكم به العقل لكونه مقدّمة لحصول العلم بالامتثال وذو المقدّمة لا يكون واجباً، لأنّ منشأه وهو وجوب الاجتناب عن الحرام المردّد غير معلوم، بل معلوم العدم بالأصل.
وبعبارة اخرى: وجوب الاجتناب في كل واحد من الأطراف، إمّا لسقوط أصالة البراءة للمعارضة بمثلها - وهي الأصل في باقي الاطراف - إن قلنا بشمول أخبار أحل ما لم يعلم حرمته للمشكوك المقرون بالعلم الاجمالي، أو لعدم كونها جارية في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي، لاستقلال العقل بوجوب الاحتياط مع وجوب تكليف متعلّق بموضوع موجود مجهول شخصه، إن قلنا بأنّ الأخبار المذكورة غير شاملة لمثل ما ذكر.
وكلا الوجهين منتفيان هنا، أمّا الاوّل: فلأنّ أصل البراءة في المورد الذي
يكون خارجاً عن ابتلاء المكلّف لا مجرى له، إذ ليس للمكلّف تعلّق به من حيث العمل حتى يجري الاصل، وعدم جريانه يكون الأصل في الطرف الآخر سليماً عن المعارض.
وأمّا الثاني: فلأنّ التكليف الفعلي غير معلوم، لاحتمال اتّحاد الموضوع الذي حكمه الحرمة، مع ما لم يكن المكلّف مبتلى به، وحينئذٍ يكون العقل حاكماً بالبراءة بالنسبة إلى ما يبتلى به المكلّف، كما أنه يحكم بها أيضاً بالنسبة إلى ذلك الموضوع.
بل يمكن أن يقال: إنّ أخبار البراءة - مثل قولهعليهالسلام : كل شيء فيه حلال(١) إلى آخره، وقولهعليهالسلام : كل شيء لك حلال(٢) إلى آخره - شاملة لما لا يكون خارجاً عن ابتلاء المكلّف فيما نحن فيه، بل وكذا أخبار أصالة الطهارة - مثل قولهعليهالسلام : كل شيء لك طاهر(٣) - وإن قلنا: إنّ تلك الأخبار لا تشمل المشتبه المقرون بالعلم الاجمالي - كما يأتي - بل كذلك أخبار الاستصحاب، وإن قلنا: بانّ الاذن في المخالفة القطعية ممكن ولا يكون قبيحاً، وقلنا: إنّ عدم جريان تلك الأخبار في أطراف العلم الاجمالي لما فيها من الدلالة على وجوب نقض الشك باليقين الاجمالي لا لعدم تعقّل الاذن في المخالفة القطعية أيضاً.
بقي الكلام في شىء: وهو أنّ تميّز موارد الابتلاء عن موارد عدمه مشكل، ومقتضى الأصل عند الاشتباه: إلحاق العلم الاجمالي - الذي شكّ في خروج بعض أطرافه عن الابتلاء - بما علم خروج بعض أطرافه عن الابتلاء، وذلك لأنّ الحكم بالبراءة فيما لم يخرج عن الابتلاء لعدم العلم بالتكليف بالاجتناب عن الموضوع المشتبه الذي أوجب جريان الأخبار في ذلك الطرف على تقدير شمولها لصورة العلم الاجمالي، وحكم العقل بالبراءة فيه على تقدير عدم جريانها، وعدم العلم يكفي فيه الشك في دخول بعض الأطراف فيما يبتلى به المكلّف كما لا يخفى.
____________________
(١) الكافي: ج ٥ ص ٣١٣ ح ٣٩.
(٢) الكافي: ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠.
(٣) مستدرك الوسائل: ج ١ ص ١٦٤ ح ٥.
وقد يقال: إنّ مقتضى الأصل وإن كان ذلك، إلاّ أنّ إطلاق أدلّة وجوب الاجتناب عن المحرّمات مانع عن جريانها في ما فرض الكلام فيه لأنّ مقتضى إطلاق تلك الأدلّة: وجوب الاجتناب حتى في ما يكون خارجاً عن الابتلاء، والقدر المتيقّن من الموارد التي خرج عنها موارد علم خروجها عن الابتلاء، وغيرها يكون خروجه مشكوكاً، والعمل بالاطلاق حينئذٍ متعيّن - لما تقرّر في محلّه - : من أنّ الشك في خروج الأفراد إذا كان ناشئاً من إجمال المقيّد للاطلاق حكمه، الرجوع إلى الاطلاق والأمر فيما نحن فيه كذلك، لأنّ الشك في موارد الابتلاء، انّما هو لعدم إمكان ضبط مفهوم المقيّد على وجه لا يخفى شيء من مصاديقه.
وفيه نظر من وجهين: الأوّل: انّ الابتلاء ليس من شرائط ثبوت الحكم في الواقع، حتى يكون إطلاق ما دلّ على ثبوته حجّة في مورد الشك في الابتلاء، بل هو من شرائط تنجّز الخطاب وفعليّة الطلب، ولا ريب أنّ إطلاق الأدلّة انما يفيد في الشرائط الموجبة لتقييد الحكم واقعاً.
والحاصل: انّ الخمر الذي يبتلي به المكلّف يكون المطلوب عدم شربه واقعاً، ولكن توجّه هذا الخطاب إلى المكلّف وتنجّزه في حقّه مشروط بكونه محلّ إبتلائه، فمع الشك في الابتلاء، لا معنى لرفع الشبهة بهذا الخطاب الموجود في حالتي الوجود والعدم، الاّ أن يقال: إنّ إطلاق الخطاب وتوجيهه إلى المكلّفين - مع عدم صحّة التوجيه إلاّ في صورة الابتلاء - كاشف عن وجود شرائط التوجيه.
وفيه وفي أصل النظر تأمّل.
الثاني: أنّا لو سلّمنا أنّ الابتلاء من شرائط ثبوت الحكم واقعا - بحيث حكمنا أنّ من خرّج المحرّم عن ابتلائه لا يكون محرّماً عليه واقعاً - نمنع أنّ الخطاب في مقام البيان - من حيث حالة المكلّفين من الابتلاء والعدم - لأنّ المطلّقات الواردة في بيان المحرّمات واردة في مقام بيان المحرّمات عن المباحات، وليست في مقام بيان من يحرم عليه، ويطلب اجتنابه عنها من هذه الجهة، حتى يكون اطلاق الخطاب في مورد الشك حجّة فتأمّل.
والحاصل: أنّ الخطابات منها ما يقصد منها الشروع الفعلي ومنها ما يقصد تشريع الحكم، والإبتلاء والعدم انّما يلاحظ في الخطابات التي من القسم الأوّل، دون ما يكون من القسم الثاني: فالتمسّك بالمطلقات الواردة في بيان تشريع الحكم لا وجه له، اذ ليست هي في مقام بيان حال المخاطب حتى يكون عدم تقييدها في هذا المقام دليلاً على الاطلاق فتأمّل في الفرق بين الاعتراضين.
التنبيه الثاني: لا ريب في أنّ العلم الاجمالي بوجود الحرام انّما يوجب الاحتياط خاصّة بالنسبة إلى كل واحد من المشتبهات، وأمّا الآثار - التي موضوعها نفس ذلك الحرام غير وجوب الاجتناب - فلا يثبت للأطراف، فمن شرب أحد الانائين اللذين أحدهما خمر لا يثبت عليه حدّ الخمر لا لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات، بل لأنّ موضوع الحكم غير ثابت.
ومن هنا انقدح: أنّ ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة لا يكون محكوماً بالنجاسة، لأن ثبوت نجاسته موقوف على إحراز كونه ملاقياً للنجس، وهذا المعنى غير معلوم، فكيف يحكم بنجاسته ووجوب الاجتناب عنه.
وقد يقال: إنّ تنجّس الملاقي وعدمه مبنيّان على أنّ تنجّس الملاقي انّما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلك النجس - بناءً على أنّ الاجتناب عن النجس يراد به ما يعمّ الاجتناب عن ملاقيه ولو بوسائط، أو أنّ الاجتناب عن النجس لا يراد به الاّ الاجتناب عن العين، وتنجّس الملاقي للنجس حكم وضعي سببي يترتّب على العنوان الواقعي من النجاسات نظير وجوب الحد للخمر - ، فإذا شكّ في ثبوته للملاقي، جرى فيه أصل الطهارة، وأصل الاباحة.
وفيه: انّا لو سلّمنا أنّ وجوب الاجتناب عن الملاقي وتنجّسه انّما جاء من وجوب الاجتناب عن النجس، نقول: إنّ ذلك لا يستلزم الاجتناب عن ملاقي المشتبه بالنجس، لأنّ تنجّز الخطاب بالاجتناب عن نفس النجس كما يكون مشروطاً بوجود نجس معلوم ولو اجمالاً، كذلك تنجّز ذلك الخطابات بالنسبة إلى الملاقي موقوف على وجود ملاقي النجس على وجه يعلم ملاقاته له، ضرورة أنّه
لا معنى لطلب الاجتناب عن الملاقي مع عدم وجوده ولو فرض العلم التفصيلي بالنجس، ولا ريب أنّ ملاقي المشتبه بالنجس لا يعلم كونه ملاقياً للنجس، وإلاّ كان المشتبه معلوم النجاسة فتأمّل.
فان قلت: هب ان الملاقي لأحد الأطراف لا يعلم كونه ملاقياً للنجس، إلاّ أنّ العلم الاجمالي بكونه أو المشتبه الآخر الذي بازاء الملاقى - بالفتح - نجساً يوجب الاجتناب، كما أنّ العلم بنجاسة الملاقى - بالفتح - أو الطرف الآخر أوجب الاحتياط بالنسبة اليهما، وهذا - نظير ما لو انقسم أحد الانائين إلى قسمين فانّه يجب الاجتناب عن كل قسم.
قلت: حكمنا بعدم وجوب الاحتياط هنا انّما هو لجريان أدلّة البراءة في الملاقي - بالكسر - العقلية منها والنقلية، كما أنّ الأمر كذلك في مسألة خروج بعض الأطراف عن الابتلاء.
أمّا جريان الأدلّة العقلية فبيانه: أنّ العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي - بالكسر - أو ما بإزاء الملاقى - بالفتح - لا يكون سبباً للعلم بتكليف بالاجتناب عن نجس، لأنّه لم يكن سبباً للعلم بوجود نجس غير الذي علمنا وجوده بين الملاقى - بالفتح - وما بإزائه فالعلم الاجمالي لم يوجب الاحتياط بالنسبة إلى الملاقي - بالكسر - لأنّه انّما يوجب الاحتياط لأجل تنجّز التكليف بوجوده والتكليف بالاجتناب في الملاقي - بالكسر - للجهل بكونه نجساً مجهول، فهو مندرج في كلّي مجهول الحكم الذي فيه البراءة وعدم وجوب الاحتياط.
وأمّا مسألة انقسام أحد الانائين بقسمين فليس من هذا القبيل، لأنّ التكليف المعلوم الذي وجب امتثاله موضوعه مردّد بين مجموع القسمين والاناء الآخر وذلك ظاهر بخلاف ما نحن فيه فان التكليف بالاجتناب موضوعه مردّد بين الملاقى - بالفتح - وما بإزائه وإن كان العلم بالملاقي(١) حاصلاً عند العلم بوجود النجاسة
____________________
(١) بالملاقاة (ظ).
بين الإنائين لأنّ وجوب الاجتناب الملاقي لا يكون مستفاداً من وجوب إجتناب النجس، بل هو حكم آخر سببي وضعي.
وأمّا الاخبار: فأمّا دلالتها على البراءة فيما نحن فيه - بناءً على شمولها للمشتبه ولو كان مقروناً بالعلم الاجمالي - فظاهر لأنّ رفع اليد عنها في كل واحد من المشتبهين انّما هو لعدم جواز الاذن في المخالفة القطعية وعدم ما يوجب التخصيص(١) ببعض الاطراف، لانّ قيام العلم الاجمالي بالملاقى - بالفتح - وما بإزائه أوجب سقوط الأصل فيهما وحينئذٍ فجريانه في الملاقي لا مانع منه، لأنّ معارضة الأصل الجاري فيما بازاء الملاقى - بالفتح - بالجاري في نفس الملاقي، موجب للحكم بخروج بعض معيّن من اطراف العلم الاجمالي الثاني - الذي يكون الاذن في المخالفة القطعية مخالفاً للعقل - عن عموم الخبر، ودخول بعض معيّن فيه تحته، والحكم بخروج معيّن من أطراف العلم الاجمالي الأوّل(٢) ، مع كون العلم بالملاقاة والعلم بوجود النجس متقاربين لا وجه له، إذ ما دام الأصل في الملاقى - بالفتح - جارياً لا يكون الملاقي - بالكسر - مجهول الحكم، حتى يكون الأصل فيه مسقطاً للأصل الذي بازاء الأصل في الملاقي فيكون سليماً عن المعارض.
وأمّا بناءً على أنّ أخبار الحلّ غير شاملة لموارد العلم الاجمالي فيمكن أن يقرّر بوجهين:
الأوّل: إنّ العلم الاجمالي بوجود النجس بين الملاقي - بالكسر - والطرف الآخر لما لم يكن حكمه الاحتياط في الملاقي - بالكسر - عند العقل كان اقتراح الشك فيه كاقتراح الشك في الشكوك البدوية وكان قيام الشك في النجاسة بالطرف الآخر بمنزلة العدم بالنسبة إلى الشك في الملاقي - بالكسر - ولهذا صار داخلاً في عموم ما دلّ على أنّ الشبهات البدوية لا يجب الاحتياط فيها، وهذا البيان بعينه جار فيما لو خرج بعض الأطراف عن الابتلاء، فانّ الشك فيما خرج عن الابتلاء بمنزلة العدم،
____________________
(١) الخروج (خ).
(٢) الثاني (ظ).
والعلم الاجمالي بوجود نجس بين ذلك وبين ما يبتلى به، لعدم اقتضائه وجوب الاحتياط بمنزلة العدم، ولهذا يكون اقتراح الشك فيه عرفاً كاقتراح الشكوك في الشبهات البدوية.
والحاصل: أنّ قوله: كلّ شيء فيه حلال وحرام(١) ، وإن كان معناه: إنّ كلّ ما شك في كونه حلالاً وحراماً وكان اشتمال النوع في الخارج أو في الذهن على قسمين سبباً للشبهة فيه، فهو لك حلال شامل لما نحن فيه، لأنّ الشبهة الخارجية لكونها بمنزلة العدم لا يكون اقتراح الشبهة شبهة، في كون هذا الملاقي أو ما يبتلى به هو النجس المعلوم، بل يكون شبهة في كون هذا الفرد داخل في عنوان النجس أم لا فتأمّل.
الثاني: إنّ الشبهة في حلّية الشيء وحرمته قسمان:
أحدهما: ما يكون مقروناً بما يوجب الاحتياط كالشبهة في أطراف العلم الاجمالي بالحرام بين امور محصورة.
وثانيهما: ما لا يكون كذلك كالشبهات البدوية وأطراف الشبهات الغير المحصورة، وأخبار الحلّ شاملة للقسم الثاني بجميع اقسامه، وأمّا القسم الأوّل فهو خارج عن عمومه، لأنّ الظاهر من الأخبار - بقرينه السؤالات وقوله: في بعض الأخبار من أجل مكان واحد يحتمل فيه الميتة حرم جميع ما في الأرض - أنّ المقصود بيان حكم الشبهات التي ليست بمقرونة بما يوجب الاحتياط، وأنّ الشبهة بمجرّدها ليست كافية في وجوب الاحتراز عن المشتبه، بل ينبغي البناء على عدم الاعتناء، ولا ريب في أنّ ما خرج مقابلة من الأطراف عن الابتلاء ومثل ملاقي المشتبه لا يكون الشبهة فيها مقرونة بما يوجب الاحتياط فيكون داخلة في الأخبار.
وبالجملة: أخبار الحلّ وإن كانت تشمل مثل الشبهة الغير المحصورة، والبدوية، والمحصورة، إلاّ أنّ المقصود لمّا علم أنّه بيان حكم الشبهة من حيث هو، لا من
____________________
(١) الكافي: ج ٥ ص ٣١٣ ح ٣٩.
حيث اقترانه بما يوجب الاحتياط، لدلالة السؤالات على ذلك، حيث إنّ الظاهر منها أنّ المقصود: السؤال عن انّ الشبهة بنفسها كافية في الاحتياط أم لا؟ بعد علمنا بأنّ المقصود ليس الترخيص في الموارد التي يجب فيها الاحتياط عقلاً وأنّها خارجة عن موردها، مضافاً إلى أنّ المركوز في الأذهان: وجوب الاحتياط في مثل الشبهة المحصورة، وهذا قرينة مانعة عن دخول مثلها تحت الأخبار، وحينئذٍ يبقى ما يكون غير مقرون بما يوجب الاحتياط تحت الأخبار.
وهذا الجواب بالنسبة إلى دلالة قوله: كلّ شيء لك حلال تمام - قد مرّ الاشارة إليها -.
وأمّا قوله: كل شيء فيه حلال وحرام - الذي سبق - أنّه غير شامل لأطراف الشبهة المحصورة، لأنّ ظاهره أنّه ما شك في حليّته وحرمته من أجل انقسام نوعه بقسمين الحلال والحرام مع قطع [ النظر ] عن وجود الحرام في الخارج وعدمه بأن يكون صرف إنقسام النوع هنا منشأ للشك، والشك في اطراف الشبهة المحصورة لا يكون ناشئاً عن انقسام النوع، فلا يجري فيه هذا الكلام إلاّ على تقدير منع ما سبق، لأنّ ذلك يوجب خروج الشبهة الغير المحصورة أيضاً عن عمومه، ويكون مخصوصاً بالشبهات البدوية.
والظاهر خلاف ذلك خصوصاً بالنظر إلى كون مورد السؤال فيها من هذا القبيل، إذ مورده فيها: الجبن الذي علم بوجود قسم حرام منه في الخارج، فلابدّ أن يكون المراد: أنّ ما اشتبه حكمه وكان وجود الحلال والحرام في الخارج سبباً للشك فيه، إمّا لاحتمال اتّحاده مع الحرام المعلوم، أو لكونه أيضاً حراماً، لجواز كون الماهية في ضمن هذا الفرد ايضاً حراماً بعد وجود النوع الحرام، وحينئذٍ يشمل جميع الموارد حتى الشبهة المحصورة، ويكون خروجها بالنظر إلى ما في الجواب، فيكون ملاقي الشبهة وما خرج مقابلة عن الابتلاء داخلاً فيه، إلاّ أن التأمّل الصادق في الخبر يشهد بخلاف ذلك، وأنّ قوله: كل شيء فيه حلال وحرام يشمل مثل الشبهة الغير المحصورة دون المحصورة، لأنّ معناه كل نوع أو فرد من نوع كان ذلك النوع
قسمين، وكان الفرد أو النوع مشكوك الحليّة لأجل اختلاط الأفراد وعدم تميّز الحلال عن الحرام يكون ذلك النوع حلالاً لا حراماً ولا ريب أنّ الأمر في الشبهة المحصورة ليس كذلك، لأنّ الشك فيها لا يكون ناشئاً من اختلاط افراد النوع وعدم تميّزها، بل هو ناش من العلم بوجود حرام مخصوص بين الموارد المخصوصة واشتباهه بالحلال، وليس الأمر كذلك في الشبهة الغير المحصورة مطلقاً، لأنّ الحرام من الطبيعة الموجودة في الخارج إذا كان مشتبهاً بين أفراد الحلال نسبته إلى الحلال من الأفراد كنسبة الواحد إلى الألف مثلاً، وكان الشك في فرد من جهة الشك في إندراجه تحت الحرام كان حكمه الحليّة بمقتضى الخبر كما لا يخفى، ولكن لا حاجة إلى هذه الرواية بعد دلالة العقل وقولهعليهالسلام : كل شيء لك حلال، في اتمام المطلب في مسألتنا هذه فتأمّل.
ثم اعلم: أنّ قولهعليهالسلام : كل شيء طاهر، نظير قوله: كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، فيجري فيه ما ذكرنا من الجوابين عن شبهة خروج ملاقي الشبهة والطرف المبتلى به من اطراف العلم الاجمالي الاجمالي الذي خرج بعض اطرافه عن الابتلاء فلا نعيده.
وأمّا أخبار الاستصحاب فبعد منع شمولها لاطراف العلم الاجمالي، لدلالتها على وجوب نقض الحكم السابق بالنسبة إلى موضوع المعلوم نجاسته المردّد بين المشتبهين المنافية لكون كل واحد من الاطراف مستقلاً داخلاً تحت قوله: لا تنقض اليقين وترجيح ظهور الأوّل على ظهور قوله: لا تنقض في الشمول لما ذكر فشمولها لمثل الملاقي - بالكسر - ومثل ما خرج عن مقابله عن الابتلاء مشكل.
التنبيه الثالث: إذا كان المكلّف مضطرّاً في إرتكاب بعض الأطراف، فإمّا أن يكون اضطراره إلى معيّن من الأطراف، أو يكون إلى غير معيّن، والأوّل: إن كان إضطراره قبل العلم الاجمالي بوجود الحرام بين المشتبهين، أو معه، أو قبل مضيّ زمان يقبح معه التكليف بالاجتناب عن ذلك الحرام، فلا يجب الاجتناب عن الآخر الذي لا يضطرّ إليه، لأنّ التكليف بالاجتناب عن الحرام الذي علم وجوده بين
الطرفين لا يعلم تنجّزه بالعلم، لاحتمال أن يكون الحرام هو الذي يكون مأذوناً في ارتكابه بالخصوص والطرف الآخر يجعل كونه الحرام.
وبعبارة اخرى: اجتماع شرائط التكليف بالاجتناب عن المحرّم الموجود بين الطرفين مجهول الحصول، لاحتمال أن يكون عين ما اضطرّ إليه بالخصوص،أو نقول: لا نعلم الآن بحرام لو علم شخصه تفصيلاً كان واجب الاجتناب، ضرورة أنّه لو كان هو ما اضطرّ إليه لم يكن واجب الاجتناب، فأصالة البراءة في الطرف الآخر سليم عن المعارض.
وإن كان اضطراره بعد العلم ومضيّ زمان يصحّ التكليف معه فيجب الاجتناب عنه، لأنّ التكليف بالحرام على أيّ تقدير - أي سواء كان ما اضطرّ اليه أم غيره - كان منجّزاً وسقوطه غير معلوم، لأنّ الاضطرار انّما أوجب الإذن في الحرام على تقدير كونه ما اضطرّ إليه فالاذن المذكور راجع إلى الاكتفاء في مقام الامتثال ذلك الخطاب بالامتثال الاحتمالي، وليس المراد هنا من الاكتفاء: بدليّة غير ما اضطرّ إليه عن الحرام، إذ ليس ما يدلّ على البدليّة كما لا يخفى.
وان كان مضطرّاً إلى واحد غير معيّن فإن كان بعد العلم فالأمر فيه واضح، وإن كان قبله أو معه فالظاهر هنا وجوب الاحتياط في غير ما ارتكبه، وذلك لأنّ التكليف بالاجتناب عن الواحد المردّد بين الطرفين، شرائط تنجّزه موجودة، إذ العلم به مفروض الحصول، والجهل بشخصه لا يكون مانعا، والاّ لمنع مطلقاً، والاضطرار ليس أيضاً متعلّقاً بالحرام ولو احتمالاً، لأنّ الاضطرار إلى أحد الأمرين لا يكون اضطراراً إلى معيّن كما هو واضح.
غاية الأمر: أنّ الجهل بالتفصيل والاضطرار إلى غير معيّن أوجب الاذن في ترك تحصيل العلم بالامتثال، وهو لا يوجب الاذن في المخالفة القطعية بعد وجود شرائط تنجّز الخطاب، فالاذن راجع إلى الاكتفاء بالامتثال الاجمالي الاحتمالي.
القول في الشبهة الغير المحصورة
وفيها مقامان(١) : (الأوّل) في حكم أطراف الشبهة (والثاني) في موضوعها.
أمّا الأوّل
فاستدلّوا على عدم وجوب الإجتناب بوجوه:
الأوّل: الاجماع المحكيّ عن جماعة بل دعوى الضرورة عليه، وأن عليه مدار المسلمين في الأعصار والأمصار.
الثاني: قوله تعالى: (يريد اللّه بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)(٢) . وقوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)(٣) . بناءً على أنّ في الاجتناب عن اطراف الشبهة مشقة أكيدة وعسراً شديداً غالباً على أغلب أفراد المكلّفين.
وفيه (أوّلاً) أنّ الحرج ليس في الاجتناب عن الحرام وانّما هو في تحصيل العلم به لكثرة المشتبهات، فليس في حكم الشارع حرج.
إلاّ أن يقال: إنّ جعل الحرج قد يكون بتأسيس انّ اللّه تعالى لا يريد العسر، فكل ما يلزم منه العسر في فعل واجب بظاهر الأدلّة، أو حرام كذلك، أو واجب بحكم العقل في طاعة أوامره ونواهيه لا يكون لازماً.
____________________
(١) كأنّ المؤلّف -قدسسره - اكتفى بالكلام حول المقام الأول فقط ولم يتطرّق حول المقام الثاني.
(٢) البقرة: ١٨٥.
(٣) الحجّ: ٧٨.
أو يقال: إنّ جعل الحرج قد يكون بانشاء حكم فيه الحرج بنفسه، وقد يكون بجعل حكم في مورد يلزم الحرج وإن لم يكن في أصل الحرج فتأمّل.
و (ثانياً) أنّ ما يدلّ عليه الآيات بظاهرها نفي العسر بنفسه، وهو انّما يقتضي الاقتصار على موضع تحقّق فيه العسر والتعدّي إلى غير مورده انّما يصحّ إذا كان ذلك من افراد موضوع الحكم الذي تعسر إمتثاله في بعض مصاديقه(١) ، لما دلّ على أنّ الأحكام الشرعية الكلّية ترفع بوجود العسر في أغلب مواردها، وأفراد الشبهات المحصورة ليست داخلة في موضوع حكم واحد، لأن سبب الاجتناب في كل مورد دليل ذلك المورد، فايجاب الاحتياط عند اشتباه النجس بغيره لو كان مرفوعاً - لكونه حرجيّاً - يلزم منه التعدّي إلى المشتبهة بالأجنبية، لأنّ(٢) وجوب الاحتياط في الأوّل انّما نشأ من قوله: اجتنب عن النجس، وفي الثاني من قوله: اجتنب عن الأجنبية.
لا يقال: ايجاب الاحتياط عند اشتباه الحرام بغيره حكم عقلي - نسبة موضوعه إلى المشتبه بالخمر كنسبته إلى المشتبه بالبول - ، لصدقه على كليهما وموافقة هذا الحكم توجب الحرج على أغلب المكلّفين وفي أغلب أقسام المشتبهات فهو مرفوع عنهم.
لأنّا نقول: الذي يدلّ عليه الأدلّة: هو أنّ الحكم الشرعي اذا لزم منه وقوع المكلّف في الحرج في أغلب مصاديقه مرفوع، وانما حكم الشارع بحرمة امور لزم الحرج على المكلّفين في امتثال تلك الاحكام عند اشتباه تلك الامور بامور غير محصورة، لحكم العقل بوجوب الامتثال اليقيني، والجامع المذكور ليس موضوعاً لحكم الشارع، وانما انتزعه العقل من الموارد الخاصة وحكم عليه بوجوب الاجتناب، لاستقلاله بوجوب تحصيل اليقين بالبراءة عند اليقين بالاشتغال، وهذا
____________________
(١) في غالب مصاديقه (ط).
(٢) في نسخة ط : « لامن » وفي النسخة الثانية « لأنّ » وهو الصحيح.
الحكم ليس حكماً شرعياً يشمله أدلّة نفي الحرج، فعلى هذا يلزم الاقتصار في ترك الاحتياط على الموارد الخاصة التي يوجب الاحتياط فيه الحرج على المكلّفين، ولا يجوز التعدّي منها إلى غيرها، وانّما يحكم في تلك الموارد الخاصة برفع الاحتياط، لأنّ الحكم الشرعي فيها مستلزم للحرج بواسطة الأمر الخارج وهو مرتفع بقدره.
أقول: وعلى هذا لا يجوز التعدّي - بلزوم الحرج من الاحتياط عند إشتباه بعض أفراد النجس بغيره من الامور الغير المحصورة - إلى ترك الاحتياط في موارد اشتباه النجس التي لا يلزم من الاحتياط فيها حرج، لأنّه ليس في الاجتناب عن النجس حرج في أغلب موارده، ولزوم الحرج من الاحتياط في أغلب موارد إشتباهه بغير المحصورة لا يوجب التعدي إلى مورد لا يوجب الحرج، لأنّه ليس الحكم بوجوب الاجتناب مخصوصاً بالنجس المشتبه فما في الرسالة من انّه يمكن التعدي هنا إلى مورد لا حرج فيه(١) لا يخلو عن النظر، ولعل في قوله أمكن التعدّي إشارة إلى تمريضه.
ويرد على أصل الدليل (ثالثاً) أنّ أغلب موارد الشبهة الغير المحصورة يكون بعض أطرافها خارجاً عن مورد إبتلاء المكلّف ولا يجب الاحتياط في مثل هذه الموارد لما تقرّر سابقاً وموارد الابتلاء لا يلزم من الاحتياط فيها حرج على المكلّفين.
الثالث: الأخبار الدالّة على حلّ ما لم يعلم حرمته، فإنّ مقتضى الجمع بينها وبين ما دلّ على وجوب الاجتناب عمّا لم يعلم حرمته: حمل الأخبار المرخّصة على الشبهة الغير المحصورة، والمانعة على الشبهة المحصورة.
ويرد عليه (أوّلاً) أنّ ايجاب الاحتياط ليس لأجل تقديم أخبار الاحتياط بل لأجل إقتضاء دليل الواقع لذلك، بعد ما مرّ الاشارة اليه من منع شمول هذه الأخبار لصورة العلم الاجمالي، لأنّ الاذن في الجميع - الذي هو ظاهر هذه الأخبار - غير معقول، وتخصيصها ببعض الأطراف دون بعض لا مرجّح له، فيكون كلّها
____________________
(١) فرائد الاصول: ص ٤٣١. طبع جامعة المدرسين.
خارجة عنها.
هذا ولكن قد مرّ: أنّ حكم العقل بعدم جواز المخالفة القطعية معلّق بعدم إذن الشارع بترك جميع المحتملات، وعدم شمول أخبار الحّل للشبهة المحصورة قد عرفت: أنّ الوجه فيه ليس ما ذكر وانما الوجه فيه ظهورها في الشبهات البدوية وما يجري مجراها بحسب العرف.
(وثانياً) أنّ أخبار الحلّ كاخبار المنع شاملة لجميع الشبهات والخارج من الاولى بالدليل موارد الشبهة المحصورة، ومن الثانية الشبهة الإبتدائية، وكلّها بظاهرها شاملة للشبهة الغير المحصورة، فلا وجه لترجيح بعضها على الآخر.
إلاّ أن يقال: إنّ إخراج غير المحصورة عن أخبار الحلّ موجب لكثرة تخصيصها، إذ قلّ ما نجد مجهولاً إبتدائياً لا يكون من أطراف شبهة غير محصورة.
وفيه: أنّ أكثر أفراد الشبهة الغير المحصورة يكون بعض اطرافها خارجاً عن محلّ الابتلاء ولا يلزم منه كثرة تخصيص. كما لا يخفى.
(الرابع) أصالة البراءة: فانّ المانع من جريانها ليس الاّ العلم الاجمالي بوجود الحرام، وهذا العلم الاجمالي لا يوجب تنجّز التكليف عند العقلاء، وانّما يكون هذا التكليف منزّلاً منزلة العدم، فانّا نرى أنّ المولى إذا أمر عبده بترك المعاملة مع زيد، واشتبه زيد عنده باشخاص غير محصورة من أهل بلده، لا يترك العبد بمجرّد ذلك المعاملة مع الاشخاص المذكورين، ولا يعدّ عاصياً عند العرف لو اتّفق معاملته مع زيد بمجرّد علمه بنهي المولى عن المعاملة مع زيد، - مع كونه مشتبهاً في هذه الاشخاص - ونرى العقلاء ايضاً يفرّقون بين احتمال سميّة واحد من ألف إناء يعلم بأنّ أحدها سمّ، وبين إحتمال سميّة أحد الانائين، فيكون الاولى عندهم منزّلاً منزلة العدم، ولا يكون ذلك العلم الاجمالي سبباً للاجتناب عن جميع تلك الاواني - مع بنائهم على عدم الاقتحام في المهالك - ولا يكون الاحتمال في الفرض الثاني بمنزلة العدم، وليس لأجل أنّ العلم الاجمالي لا يكون وجوده عندهم إلاّ كعدمه، ويكون الاحتمال القائم بكل طرف كالاحتمال في الشبهة البدوية - التي بناؤهم
فيها على عدم الاعتناء -.ولك أن تقرّر بوجه آخر وهو: أنّ العلم الاجمالي وإن كان سبباً لتنجّز التكليف بالحرام الموجود في المشتبهات، إلاّ أنّه لمّا كان الموجب للاحتياط في الأطراف قيام إحتمال كونه المحرّم الذي يجب الاجتناب عنه ويترتّب على ارتكابه العقاب بحكم العقل، لوجوب دفع الضرر المحتمل، لم يجب الاحتياط هنا، لأنّ كلاًّ من الأطراف إذا لوحظ بنفسه، كان إحتمال ترتّب العقاب عليه لاحتمال كونه المحرّم الواقعي ضعيفاً، - بحيث لا يعتني العقلاء بمثل هذا الاحتمال كاحتمال وقوع حائط محكم البنيان وكان العقل لكون الاحتمال عنده بمنزلة العدم فجوّز إرتكابه - وحينئذٍ نقول: إذا عاقب الشارع على مثل هذا المشتبه - إذا اتّفق كونه المحرّم الواقعي - يعدّ عقابه عند العقلاء عقاباً بلا برهان وقبيحاً.
إلاّ أن يقال: إذا فرض أنّ العلم الاجمالي منجّز للواقع، وكان إحتمال العقاب في كل فرد من الاطراف قائماً - على تقدير كونه الحرام الواقعي - لم يكن مجدياً إذن العقل في الارتكاب وتأمينه، فانّ حكمه هذا إخراج للطرف عن موضوع التكليف، ولا يوجب ذلك عدم العقاب على مخالفة الواقع - على تقدير مصادفة ما أذن فيه العقل للحرام الواقعي بسبب هذا الاذن - واحتمال كون العقاب بلا بيان مناف لتسليم كون العلم الاجمالي منجّزاً للأمر بالاجتناب عن المحرّم الواقعي، إذ معنى كونه منجّزاً ليس الاّ كون الحجة من قبل الشارع تماماً، فالأولى ما تقدّم: من أنّ هذا العلم الاجمالي - بعد إشتباه الحرام بامور كثيرة - لا يكون متمّماً للحجة، وموجباً للخوف في الوقوع في المهلكة، ومعه يبقى التكليف بالحرام تكليفاً بلا بيان.
ويمكن التنزّل عن هذا التقرير ويقال: إنّ من المعلوم عندنا هو أنّ العقلاء إذا علموا بوجوب ما يجب التحرّز عنه في امور غير محصورة، لا يوجب ذلك العلم وقوفهم عن ارتكاب المشتبهات والتحرّز عنها، وإن لم يكونوا مجوّزين لارتكاب الجميع، لحصول العلم معه بالوقوع في المهلكة، كما يعلم ذلك: من ملاحظة امتثال اشتباه زيد الذي نهي العبد عن المعاملة معه، فانّه لا يقف بذلك عن المعاملة ولا يجترى على
استقصاء الجميع ولو تدريجاً.
وبالجملة: لا يكون هذا العلم الاجمالي منجّزاً للحرام على جميع التقادير عند العقلاء، وهذه الدعاوي صادقة في بادئ النظر، ولكن لا بحدّ يورث الاطمئنان بعد التأمّل.
الخامس: أنّ الغالب عدم ابتلاء المكلّف إلاّ ببعض معيّن من محتملات الشبهة الغير المحصورة، ويكون الباقي خارجاً عن محلّ ابتلائه وقد مرّ أنّ الاجتناب في مثله لا يجب مع حصر الشبهة.
وفيه: أنّ محلّ الكلام أعمّ من ذلك، بل الكلام في غير ما خرج بعض أطرافه عن محلّ الابتلاء، وكون الغالب ما ذكر لا يوجب الترخيص في غيره.
السادس: الأخبار الخاصة الدالّة على أنّ مجرّد العلم بوجود الحرام بين امور كثيرة لا يوجب حرمة الجميع ووجوب الاجتناب عنها: كرواية أبي الجارود قال: سألت أبا جعفرعليهالسلام عن الجبن فقلت: أخبرني من رأى أنّه يجعل فيه الميتة ؟ فقالعليهالسلام : أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرّم جميع ما في الأرض؟ فما علمت منه ميتة فلا تأكله، وما لم تعلم فاشتر وبع وكل، واللّه إنّي لأعترض السوق فأشتر اللحم والسمن والجبن، واللّه ما أظنّ بكلّهم يسمّون(١) .
فانّ قولهعليهالسلام : « أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة » ظاهر في أنّ مجرّد العلم بوجود الميتة لا يوجب الاجتناب عن جميع محتملاته، كما أنّ الظاهر من قولهعليهالسلام : « لا أظنّ بكلّهم » إرادة العلم بوجود من لا يسمّي فيهم حين الذبح، كالسودان المذكورة في الخبر.
وفيه: منع ظهور قوله: « أمن أجل إلى آخره » في ذلك، بل يحتمل أن يكون منه ان مجرّد جعل الميتة في مكان لا يوجب أن يكون غيره من الاماكن ليجعل في الميتة فيكون حراماً وكذلك نمنع ان قوله(٢) لا أظن بكلّهم يسمّون ظاهر في إرادة القطع
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ح ٥ ج ١٧ ص ٩١ مع اختلاف فيه.
(٢) ومنع ظهور قوله (خ).
بعدم تسمية بعضهم بل المراد بعد ذلك وبيان أنّه لا يجب أن يكون الانسان قاطعاً بحليّة ما يريد تناوله بل يكون احتمال حليّته كافياً في جوازه ظاهراً ولو كان الاحتمال مرجوحاً.
أو نقول: إنّ المراد أنّ ما يكون مشتبهاً بالحرام إذا كان في سوق المسلمين - ولو علم بوجود الحرام فيما يكون في السوق - لا يجب الاحتراز عنه، لأنّ سوق المسلمين أمارة للحليّة وإن لم يكن عليه يد المسلم، إلاّ أن نمنع كون السوق أمارة مع العلم الاجمالي هذا ما سمعته من السيد الاستاذ فالقول: احتمال كون المراد ذلك كاف في ردّ الاستدلال الاّ أن يدّعي القطع بعدم ذلك ولكن يمكن أن يقال، ولا يخفى أنّ حمل قولهعليهالسلام : « ما أظنّ » على إرادة العلم الاجمالي يؤيّد كون المقصود من قوله: « من أجل »(١) ما ذكره المستدلّ ثم إنّ في الرسالة بعد ذكر الأدلّة ما هذه عبارته: وقد عرفت أنّ أكثرها لا يخلو من منع أو قصور ولكن المجموع منها لعلّه يفيد القطع أو الظنّ بعدم وجوب الاحتياط والمسألة فرعية يكتفى فيه بالظن(٢) .
وفيه: انّ كون المسألة فرعيّة مسلّم، إلاّ أنّ حجيّة هذا الظن فيها مبنيّة على حجيّة الظن المطلق، ضرورة أنّ الظن الحاصل من مجموع امور لا تكون دالّة ولا يستند ذلك إلى ظهور لفظي بعد الجمع بينهما لا يكون الاّ ظنّاً مطلقاً.
والحاصل: أنّ الاجماع المحكي إن كان بالغاً درجة الحجّية فهو المستند، وإلاّ فالظنّ الحاصل بضميمة غيره من الأدلّة لا يمكن الركون إليه ما لم يستند إلى ظهور لفظي.
واعلم أنّ مقتضى حكم العقل - كما مرّ - هو الاجتناب عن جميع الأطراف إلاّ أن يثبت الاذن من الشارع في ترك الاحتياط، فنقول: مقتضى حكم الدليل العقلي - وهو الدليل الرابع - جواز ارتكاب الكلّ تدريجاً ما لم يقصد ذلك من أوّل الأمر، لأنّ ضعف الاحتمال الموجب لتأمين العقل ثابت في كل من المحتملات،
____________________
(١) مكان واحد (خ).
(٢) فرائد الاصول: ص ٤٣٥، ذيل مبحث الشبهة غير المحصورة.
غاية الأمر أنّه يحصل - بعد ارتكاب الجميع - العلم بأنّ الحرام قد حصل ارتكابه، وتحصيل العلم بذلك لا دليل على حرمته - كما مرّ - في المحصورة.
وأمّا إذا قصد الجميع أوّلاً سواء كان لأجل تناول الحرام أو لداع آخر، فالظاهر أنّه حرام لعدّ ارتكابه معصية ويكون معاقباً في ارتكاب الحرام وان كان هو أوّل ما ارتكبه، وأمّا العقاب على غيره(١) - على الأوّل - فهو مبنيّ على مسألة التجرّي.
وأمّا الأخبار فقد يقال: إنّها إن كان تامّ الدلالة تدلّ على حليّة الجميع قلت: إن قلنا بأنّ الاذن في المخالفة القطعيّة من الشارع ممنوع فالعمل بالأخبار مشكل، لأنّ ظاهرها لا يمكن العمل به، وتخصيصه ببعض المحتملات دون بعض، ترجيح بلا مرجّح، ويجب العمل بما يأتي ذكره، وإن قلنا: بأنّ الاذن فيها جائز قلنا حينئذٍ بجواز إرتكاب الجميع - وإن قصد الارتكاب من أوّل الأمر -، لأنّ المفروض أنّها تدلّ على أنّ الحرام الموجود في المشتبهات لا يكون منجّزاً وحينئذٍ لا يصدق - مع قصد الجميع من أوّل الأمر على إرتكابه - أنّه معصية، والفرق بين هذا الوجه والدليل العقلي: أنّ العقل إنّما كان يرخّص في كلّ من المحتملات بشرط الانفراد، إذ المناط فيه ضعف الاحتمال، ومع ضمّ بعضها إلى بعض يحصل القطع بالعقاب، بخلاف الأخبار فانّ الاذن فيها ليس مقيّداً بصورة قصد الانفراد.
ويمكن أن يقال: إنّ الاجماع قام على أنّ إرتكاب الشبهة الغير المحصورة جائز في الجملة، وهذا الوجه يوجب خروج ذلك عن أخبار الاحتياط، ودعوى خروج هذه الشبهة عن أخبار الحلّ ما لم يعلم حرمته، أيضاً بعيد لبعد خروجه عنهما، وعدم التعرّض لحكمها من الائمةعليهمالسلام ، وحينئذٍ نقول: إنّ الاذن في المخالفة مطلقاً، إن كان جائزاً فالأمر واضح، وإن لم يكن جائزاً فنقول: القدر الذي يمنع منه العقل هو الاذن في ارتكاب الجميع، وذلك ينتفي بإبقاء مساوي الحرام،
____________________
(١) في هامش إحدى النسختين توجد هذه العبارة « الظاهر زيادة هذه الكلمة » ويعني بها « على غيره ». ولكن الصحيح كما يبدو أن كلمة « على غيره » غير زائدة بل الزائد هو الواو في « وإن كان هو. ».
مقدار ما يساوي الحرام جائز، - إن قصد ذلك الارتكاب تدريجاً -.
وأمّا الأخبار الخاصة: فلا دلالة فيها على جواز ارتكاب الجميع والعدم، فتأمّل. وإن منعنا دلالة الأخبار وحكم العقل بجواز الارتكاب، فيمكن أن يقال حينئذٍ: إنّ الثابت بالاجماع: هو ارتكاب الشبهة في الجملة، وذلك لا يوجب الاذن في الجميع، فان قصده من أوّل الأمر فلا يجوز الارتكاب مطلقاً، لصدق المعصية، وإن قصد البعض فيجوز إرتكابه، وذلك جائز إلى مقدار ما يساوي الحرام، وأمّا هو فلا يجوز إرتكابه، لعدم دليل على جوازه إن قلنا: إنّ الاذن في الجميع ممكن، وإلاّ فالدليل على خلافه موجود.
قلت: ان ثبت الاجماع على الرخصة في غير ما يساوي فهو، والاّ فمجرّد العلم بالرخصة في البعض لا يوجب جواز ما عدا ذلك المقدار، بل الواجب: الاقتصار على ما يقطع جوازه من المقادير - بعد اجتناب ذلك(١) - ممّا يكون إحتمال حرمته أضعف من غيره، إن كان بين المحتملات تفاوت بالقوّة والضعف، واختيار ما شاء منها إن لم يتفاوت لعدم المرجّح.
والحاصل: انّ من بنى على كون العلم الاجمالي منجّزاً يجب عليه حينئذٍ القول بأنّ الاذن في بعض الأطراف إمّا يجعل اجتناب ما يساوي الحرام بدلاً عن المحرّم الواقعي، وإمّا الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي عن الامتثال اليقيني، لتعسّر الامتثال اليقيني على المكلّف، أو لحكمة اخرى أوجب رفعه عن المكلّف ولا يعلمه، ولا يمكنه القول: بجواز إرتكاب الجميع لا مع القصد ولا بدونه، إلاّ إذا بنى على أنّ تنجّزه تعليقي، وأثبت الاذن من الشارع مطلقاً، أو على تقدير بعض الوجوه.
الكلام في الشك في الجزئية
إذا تعلق الأمر بماهية ذات أجزاء وعلم لها أجزاء وشك في أنّ لها جزء آخر من
____________________
(١) الظاهر « واختيار ذلك » بدل قوله « بعد اجتناب ذلك ».
الأفعال الخارجية غير الأجزاء المعلومة ؟ كما لو شك في جزئية الاستعاذة في الصلاة ففي وجوب الاحتياط وعدمه إشكال، وذهب إلى كل جماعة وقال شيخناقدسسره في الرسالة: لم أعثر في كلمات من تقدّم على المحقّق السبزواري على من يلتزم بوجوب الاحتياط في الأجزاء والشرائط، وإن كان فيهم من يختلف كلامه في ذلك، كالسيد والشيخ والشهيد(١) انتهى ويحتمل أن يكون تمسّكهم بالاحتياط أيضاً على وجه التأييد، لأنّ حسن الاحتياط بديهي، وأمّا أصالة البراءة فبعد بطلانها لا وجه للتأييد بها.
احتجّ القائلون بالبراءة بوجوه: الأوّل: استقلال العقل بأنّ المولى اذا أمر عبده بمركّب من عدّة امور ولم يعلمه إلاّ ببعض تلك الامور، والعبد لم يأت بغيرها للشك في أنّ(٢) غيرها له دخل في المطلوب، وعدم ظفره بعد المبالغة في الفحص والتتّبع عن دليل يقضي بالوجوب أو العدم بعدم جواز عقاب العبد على ترك ذلك، وعدم كونه فاعلاً للقبيح اذا فعل ذلك، فالواجب على الحكيم: إمّا أن يعذّر العبد، أو ينصب له طريقاً إلى وجوب الجزء المشكوك على وجه يطلع عليه العبد.
فان قلت: التكليف بالماهية المردّدة بين الأقلّ والأكثر معلوم، وقضية العلم به هو الاحتياط، ولو كان الجهل تشخيص المكلّف به مانعاً عن وجوب الاحتياط لمنع عن وجوبه في غير هذا المورد من الموارد التي وقع الاتّصاف فيها على وجوب الاحتياط، كما في قسمي الشبهة المحصورة - أعني ما يكون منشأ الاشتباه فيها الامور الخارجية وما ليس كذلك، كتردّد الواجب بين الظهر والجمعة - قلت: فرق بين المقام وموارد الشبهة المحصورة لأنّ العلم الاجمالي بوجوب الأمر المردّد بين الأقل والأكثر يلزمه بعد العلم بأنّ الاكثر لو كان واجباً كان الأقل واجباً من باب المقدمة انحلاله إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل على أيّ تقدير وشك بدوي في وجوب الاكثر الناشئ من الشك في وجوب الزائد، وليس الأمر كذلك في موارد الشبهة، ولو
____________________
(١) فرائد الاصول: ص ٤٦٠.
(٢) وفي نسخة « أنّه » والظاهر ما أثبتناه.
فرضنا فيها أيضاً انحلال العلم الاجمالي إلى ما ذكر ذلك بمعونة خصوصية في المورد، فلا تلزم بوجوب الاحتياط هنا أيضاً، كما إذا تردّد الخمر بين إنائين يعلم بنجاسة أحدهما المعيّن فانّ الظاهر منهما محكوم بجواز الاجتناب.
والحاصل: أنّ إجمال العلم إذا كان سبباً للجهل بخصوصية المكلّف به فالواجب لأجله هو الاحتياط وليس الجهل عذراً وإذا كان سبباً للجهل باصل التكليف بعد العلم بالتكليف في مقدار معيّن، فلا يجب الاحتياط في المشكوك بسببه، لأنّ العقل مستقلّ بوجوب بيان التكليف.
وبما ذكرنا يندفع ما قد يورد على القائل بالبراءة: من أنّه إذا كان الاكثر على تقدير كونه هو المكلّف به لا يجب الاتيان به ولا عقاب على تركه، لأنّ الاصل براءة الذمة عنه، لأجل أنّ المكلّف جاهل بهذا التقدير، ولم يثبت من الشارع بيان بالنسبة اليه، فلا يجب الاتيان بالأقل ايضاً لأجل العلم الاجمالي، إذ بعد فرض فراغ الذمة عن التكليف بالاكثر، لا يكون وجوب الأقل إلاّ مشكوكاً فالأصل براءة الذمة عند وجه الدفع أنّ الشك في وجوب الأكثر انّما يلازم الشك في وجوب الاقل لنفسه، وأمّا وجوبه الأعم من النفسي والغيري فلا يكون مشكوكاً، وانقطاع الاصل بالنسبة إليه يكفي فيه هذا المقدار من العلم.
فان قلت: سلّمنا أنّ الأقل معلوم الوجوب والزائد مشكوك ولكن ذلك لا يقتضي أن لا يكون الزائد لازم الاتيان بل ذلك يقتضي الاحتياط، لأنّ القطع بفراغ الذمة عن الأقل لا يحصل الاّ بالاتيان بالاكثر، لأنّ الأقل إمّا مطلوب وحده، وإمّا مطلوب في ضمن الكل، فالقطع بالفراغ عن التكليف المتعلّق به لا يحصل إلاّ باتيانه في ضمن الكل وهذا نظير تردّد الواجب بين القصر والاتمام الاّ أنّ الاحتياط هنا يمكن بغير الجميع دون هنالك.
قلت: أمّا أنّ الأقل مطلوب في ضمن الكل على تقدير وجوب الأكثر.
ففيه المنع، لأنّ وجوب الأقل ليس الاّ لأجل توقّف الكلّ المركّب منه ومن غيره عليه والكل متوقّف على ذات الأقل وأمّا هو منضمّاً إلى غيره فهو ليس الاّ عين
الكل فالأمر به ليس الاّ أمراً بالكل، وأمّا أنّ الامتثال لا يحصل - على تقدير كون الأكثر هو الواجب - إلاّ باتيانه في ضمن الكل، ففيه أنّ اتيان الجزء مسقط للأمر به، لأنّ موافقة ذلك الأمر بعد فرض تعلّقه بذات الجزء قد حصل فلا معنى لعدم سقوطه، لأنّ الأمر يقتضي الاجزاء بالبديهية واما الأمر به بعد خروجه عن صلاحية لحوق سائر الاجزاء فليس لأجل أنّ الأمر الأوّل باق، بل لأجل أنّه فسد بذلك ومع فساده لم يحصل الغرض المقصود من الأمر به وهو التوصل إلى الكل، نظير إفساد الوضوء بالحدث فيعود الأمر وإذا حصل الامتثال بالأقل أوّلاً فيما نحن فيه سواء كان وجوب لنفسه أو لغيره فعود الأمر به ثانياً - بعد خروجه عن صلاحية لحوق سائر الاجزاء - يحتاج إلى دليل والمفروض عدمه.
فان قلت: سلّمنا وجوب الاقل وأنّه يحصل الامتثال به على أيّ تقدير ولكن نقول ترتّب العقاب على مخالفة هذا الأمر مشكوك، لأنّه لو كان الواجب الواقعي هو الأكثر لا يكون الخطاب منجّزاً، وحينئذٍ لا يترتّب على ترك الأقل أيضاً عقاب، وإذا كان الأمر كذلك فلا يلزم اتيان الأقل، ولو كان وجوبه معلوماً وحينئذٍ يلزم جواز المخالفة القطعية.قلت: احتمال ترتّب العقاب على ترك الأقل مع عدم ما يوجب الآمن منه كاف في إلزام العقل بوجوب الاتيان به مع أنّه على تقدير وجوب الاكثر يكون ترك الأقل تجرّياً ومستلزماً للعقاب إن قلنا فيه بالعقاب.
والحاصل: أنّ الأمر بالأقل معلوم، لأنّه إمّا واجب واقعاً في نفسه، وإمّا واجب واقعاً للغير، وإحتمال سقوطه بسقوط الأمر بالأكثر - إن كان هو الواجب - لا يجدي في ترخيص العقل على مخالفته.
فان قلت: سقوط الأمر بالأقل موقوف على قصد القربة، وهو لا يمكن الاّ مع قصد الاتيان بالأكثر.
قلت: يكفي في صدق الامتثال قصد الفرار عن مخالفة الأمر وما يترتّب على مخالفته، وإن لم يعلم بحصول القرب - كما يأتي بيانه -.
والحاصل: أنّ العقل مستقلّ بعدم لزوم إتيان الزائد مادام كونه مشكوك الوجوب، لاستقلاله بأنّ العقاب على مخالفته مع عدم البيان قبيح، ومستقلّ أيضاً بوجوب إتيان الأقل للفرار عن ترتّب العقاب على تركه - وإن كان إحتمالياً - لحصول اتمام الحجّة بالنسبة إليه.
فان قلت: حكم العقل بعدم وجوب الاتيان بالزائد ممنوع، لأنّا نرى أنّ الطبيب إذا أمر بمعجون ذي أجزاء ليس بناء العقلاء فيه على الاكتفاء بما علم من أجزائه، ولو اكتفى المريض بذلك مع علمه بأنّ الجزء المشكوك ليس بضارّ يستحقّ اللوم، وكذلك العبيد بالنسبة إلى أوامر مواليهم، فانّهم إذا اكتفوا بما علموا من الأجزاء ولم يأتوا بالجزء المشكوك - مع العلم بأنّه ليس مبغوضاً للمولى - يستحقّون اللوم والذمّ، ولا يقبح على المولى توبيخهم على ترك المشكوك إذا انكشف أنّه داخل في المركّب المأمور به.
قلت: الأوامر الصادرة من المولى قد يكون المقصود منها تحصيل أمر في الخارج بحيث يعلم أنّ الغرض انّما تعلق بحصول ذلك الأمر والأمر بالمركّب انّما هو لأجل كونه محصّلاً، وأنّ الذي يطلبه المولى من عبده حقيقة هو تحصيل ذلك الشيء وقد لا يكون كذلك، أمّا في الصورة الاولى فيجب الاحتياط فيها، لأنّ مع الشك في الاتيان بما يوجب حصول ذلك الشيء شك في الاتيان بالمأمور به رأساً، ولا ريب أنّ الاشتغال به يقتضي القطع بالبراءة عنه، ومن هذا القبيل أوامر الأطباء إذ المقصود منها ليس مجرّد استعمال ما قررّه الطبيب، بل المقصود حصول الأثر المترتّب على الداء الذي رتّبه.
نعم فرق بين أوامر الاطباء والموالي، فانّ الاولى إرشادية محضة، وأوامر الموالي يكون المقصود منها إطاعة العبد.
وأمّا الصورة الثانية: - أعني ما لم يعلم أنّ الغرض من الأمر حصول أمر بسيط مرتّب على هذا المركّب الذي تعلّق الأمر به ظاهراً - فبناء العقلاء فيها على الاحتياط ممنوع، بل على المولى البيان، فكلّ ما علمه العبد وتركه يكون معدوداً في العصاة
بسبب تركه، وما لم يعلم أنّه مطلوب فتركه لا يعدّ معصية - وإن إنكشف أنّه مطلوب المولى - وليس على المولى مؤاخذته على تركه.
والحاصل: أنّ المولى مع قدرته على رفع جهل العبد - ولو على طريق خارج عن المتعارف - إذا لم يبيّن المشكوك ليس له المؤاخذة من عبده لترك المشكوك.
نعم لو كان الشك في مطلوبية الجزء المشكوك راجعاً إلى الشك في علّة حصول المأمور به في الخارج، وأنّه هل هي الأجزاء المعلومة أم هي تلك مع الأجزاء المشكوكة - كما في الصورة الاولى - وجب الاحتياط، لأنّ بيان ما يوجب حصول المأمور به على وجه يقطع العبد به مع كونه قادراً على الاتيان في حال الشك ليس بلازم على المولى، ولو تركه لا يكون ذلك قبيحاً وانّما اللازم عليه اتمام الحجّة بالنسبة إلى أصل المأمور به.
فان قلت: أوامر الشارع على قول العدلية كلّها من قبيل الصورة الاولى، لابتنائها على المصالح التي ما هي إمّا عناوين لما أمر بها، أو أغراض لتلك الأوامر، فانّ الامور المترتّبة على إتيان المأمور به: إمّا أن يكون من خواص ذات المأمور به كالاسهال المترتّب على ذات الدواء المشروب، أو من الامور المترتّبة على إتيانه بقصد الطاعة وموافقة الأوامر، فان كانت من قبيل الأوّل يكون عنواناً للمأمور به، نظير اسهال الصفراء، فان الأمر بالدواء الذي خاصيته ذلك أمر بمسهل الصفراء، وإن كانت من قبيل الثاني فهي أغراض من الأوامر المتعلّقة بتلك الامور، إذ المفروض أنّ الخاصيّة ليست مترتّبة على ذات المأمور به، بل هي مترتّبة عليه إذا انضمّ إليه أمر خارج عنه - وهو قصد القربة - وذلك مثل الألطاف في الواجبات العقلية التي تترتّب على العبادات إذا اتي بها بقصد الاطاعة والانقياد.
والحاصل: أنّ الأوامر الشرعية - تعبّدية كانت أو توصّلية - مبنيّة على مصالح هي إمّا عناوين للمأمور به، كما في التوصّليّات وكالفوائد المترتبة على ذات المأمور به في التعبّديّات، وإمّامن قبيل الأغراض كالامور المترتبة على العبادات اذا اتي بها بقصد الاطاعة، وعلى أيّ تقدير لا يحصل القطع بحصول تلك المصالح إلاّ بعد
الاتيان بجميع ما يحتمل أن يكون داخلاً في المأمور به فيجب إتيان ذلك تحصيلاً للقطع بحصول ما وجب تحصيله.
قلت أوّلاً: الكلام في مسألة البراءة والاحتياط ليس مبنيّاً على مذهب العدلية، بل هو جار على جميع المذاهب حتى الأشاعرة المنكرين للحسن والقبح.
لا يقال: الذي ينكره الأشاعرة لزوم أن يكون المقصود من الأوامر حصول أمر مترتّب على المأمور به، وهم لا ينكرون جواز ذلك واحتمال ذلك كاف في وجوب الاحتياط.
لانا نقول: ما لم يعلم ذلك لا نحكم بوجوب الاحتياط، لأنّ ما علم الأمر به حينئذٍ ليس إلاّ ما تعلّق الأمر به ظاهراً، وغيره مشكوك وتحصيل الغرض المشكوك غرضيته ليس بلازم فتأمّل. حتى على مذهب من يختار من العدلية أنّ منشأ الأوامر وجود المصلحة في نفس أمر الآمر وإن لم يكن في المأمور به بنفسه، أو مع قصد الاطاعة مصلحة.
وثانياً: أنّ القائلين بابتناء الأوامر على المصالح قائلون بانّه يعتبر في إمتثال الأوامر التعبدية من قصد الوجه، وإذا شككنا في أنّ المأمور به هو الأقل أو الاكثر فلا يمكن لنا قصد الوجه، إذ هو فرع المعرفة به، وحينئذٍ نقول: يمكن أن يكون الغرض المترتّب على المأمور به مترتّباً على الاتيان به بقصد الاطاعة مقروناً بقصد الوجه، وعند ذلك نشك في التكليف بتحصيل الغرض، وهذا نظير ما إذا علم إجمالاً بوجوب شيء مردّد بين أمرين وكان عند العلم بالأمر أو قبله مضطرّاً في ترك بعض تلك الامور، فانّ العلم الاجمالي حينئذٍ لا يكون موجباً لتنجّز التكليف بذلك الأمر المردّد، وحينئذٍ فلا يبقى علينا إلاّ وجوب التخلّص عن تبعة هذا الأمر المعلوم المتعلّق بذات المركّب من العقاب على مخالفته.
فان قلت: فحينئذٍ لا يجب الاتيان بالأقلّ لأنّ الشك في إمكان حصول الغرض شك في أصل الأمر، لأنّ المفروض أنّ الأمر مترتّب على المصلحة فمع الشك فيها نشك في أنّه هل وجب علينا شيء أم لا؟ وقد سبق أنّ الشك في أصل التكليف
لا يوجب الاحتياط والأصل عنده هو البراءة.
قلت: ثبوت التكليف بالأقل ممّا لا ريب فيه واحتمال عدم التمكّن من تحصيل الغرض الباعث على تعلّق الأمر بالأمر المردّد عند المكلّف بين الأقلّ والاكثر لا يوجب رفع اليد عن الخطاب المعلوم، وإن كان الاحتمال، موجباً للشك في حدوث التكليف، وليس بناء العقلاء في مثل هذا المورد على البراءة، ولا يحكم العقل بمعذورية المكلّف لو كان ما تعلّق به الخطاب واقعاً هو الأقلّ.
والحاصل: أنّ الأمر بالشيء اذا ثبت عند المكلّف فاحتمال عدم كون الغرض ممّا يمكن تحصيله لا يوجب سقوط التكليف، وليس هذا لأجل أنّ تحصيل الغرض ولو احتمالاً واجب حتى يقال: بوجوب الأكثر حينئذٍ، بل لأجل أنّ الحجّة بالنسبة إلى ما علم تعلّق الأمر به تامّة، وإن كان الأمر مردّداً بين النفسي والغيري، وبين ما يترتّب على مخالفته العقاب وما لا يترتّب على مخالفته العقاب، ولا يخفى أنّ هذا الجواب انّما يتمّ عند من لا يرى جواز الاكتفاء بقصد القربة عند التمكّن من قصد الوجه، وأمّا عند من يدّعي القطع بأنّ قصد الوجه لا يكون له دخل في باب الاطاعة حتى في التعبّديّات، فالأمر في مقام الجواب عن هذا الاشكال عليه مشكل.
ويمكن أن يستدلّ لجواز الاكتفاء بالأقلّ: بأصالة عدم وجوب الاكثر، ولا يعارض باصالة عدم وجوب الأقل، لأنّ الأصل بالنسبة إليه لأجل العلم بتعلّق الأمر به منقطع وساقط، وتردّده بين النفسي والغيري لا يمنع عن كون العلم به مسقطاً للأصل كما لا يخفى.
لا يقال: إن قصد بهذا الاصل نفي أثر الوجوب الذي هو استحقاق العقاب على الترك، ففيه: أن عدم استحقاق العقاب ليس من آثار عدم الوجوب الواقعي حتى يحتاج إلى إحرازه بالأصل، بل يكفي فيه عدم العلم بالوجود، فمجرّد الشك فيه كاف في عدم استحقاق العقاب بحكم العقل القاطع، وإن قصد به نفي الآثار المترتّبة على الوجوب النفسي المستقلّ، فأصالة عدم هذا الوجوب في الأكثر معارض بأصالة عدمه في الأقل، فلا يبقى لهذا الأصل فائدة إلاّ نفي ما عدا العقاب من الآثار
المترتبة على مطلق الوجوب الأعم من النفسي والغيري.
لأنّا نقول: إنّ التمسّك بالأصل انّما هو مع قطع النظر عن حكم العقل بالبراءة، ولا ريب أنّه مع فرض عدم وجود دليل كاف في إثبات البراءة يكون دليلاً مقتضياً لنفي العقاب على مخالفة الخطاب المشكوك الثبوت على تقدير وجوده، ويكون وارداً على حكم العقل بوجوب الاحتياط لو فرض حكمه ذلك، كما يدّعيه القائلون بالاحتياط.
وقوله: انّ عدم استحقاق العقاب من آثار عدم الوجوب الواقعي.
ففيه: أنّ استحقاق العقاب انّما هو من آثار مخالفة الخطاب المعلوم ثبوته عند المكلّف، فسبب إستحقاق العقاب على المخالفة هو الوجوب المعلوم، وهذا المركّب كما يكون مرتفعاً بعدم العلم، كذلك يكون مرتفعاً بارتفاع أصل الوجوب، وإذا فرضنا أنّ إرتفاع المركّب الذي هو علّة للاستحقاق يكون بأحد أمرين، كذلك يكون معلوله الذي هو عدم الاستحقاق مستنداً بأحد أمرين، فعند إنتفاء الوجوب واقعاً يكون عدم استحقاق العقاب مستنداً إلى ذلك، وعند ثبوته واقعاً وهو مجهول كان العدم مستنداً إلى عدم العلم بالوجوب إن فرض أنّ عدم العلم كان كافياً في رفع الاستحقاق كما في بعض الموارد.
لا يقال: عدم العلم بالوجوب بمنزلة قضيّة سالبة تجمع مع عدم الوجوب واقعاً، فهو عند عدم الوجوب أيضاً مستحق(١) ، وانّما يتبيّن ما ذكرت من إستناد رفع استحقاق العقاب بانتفاء نفس الوجوب في بعض الموارد إذا كان عدم العلم متخلّفاً عن عدم الوجوب في مورد تحقّقه.
والحاصل: أنّ عدم العلم أعم من عدم الوجوب، وانّما يعلم تعدّد سبب رفع الاستحقاق إذا فرض بينهما المباينة الكلية.
لأنّا نقول: لا ريب في أنّ عدم الوجوب قابل لاستناد عدم العقاب إليه، كما أنّ
____________________
(١) متحقّق (ظ).
عدم العلم به أيضاً قابل لذلك، وإذا فرض اجتماع أمرين يمكن إستناد شيء إلى كل منهما يكون السابق هو المستند إليه، ولا ريب أنّ عدم الوجوب سابق على عدم العلم به، ولو فرضنا عدم العلم أو عدمه فالحكم بالاستناد إلى أحدهما المعيّن لا وجه له فتأمّل.
ويمكن أن يكون المقصود في(١) الاحتياج إلى الأصل: أنّ مع عدم العلم من دون طريق تعبّدي تقطع بعدم العقاب وإن فرض عدم الاستناد إليه في الواقع، فلا حاجة إلى إثبات العدم، ولكنّك قد عرفت أنّ الكلام مع قطع النظر عن كفاية عدم العلم بحكم العقل بالبراءة، وأنّ المقصود إثبات البراءة ولو فرض أنّ العقل لا يحكم بها.
فان قلت: لو سلّمنا تماميّة الأصل فلا يترتّب عليه إلاّ الآثار الشرعية التي هي ثابتة لعدم الوجوب، ولا ريب أنّ عدم إستحقاق العقاب ليس من الآثار الشرعية، كما أنّ استحقاقه أيضاً ليس من آثار الوجوب التي تثبت بالشرع، بل الحاكم بالترتّب في الموردين هو العقل.
قلت: ليس المقصود من التمسّك من الأصل إثبات عدم العقاب بحكم الشرع حتى يقال: إنّ الاستصحاب لا يثبت الآثار العقلية، بل المقصود منه إثبات ما يلزمه عدم العقاب عقلاً - وهو عدم الوجوب في الظاهر - كما أنّ المثبت من إستصحاب الوجوب ليس إلاّ الوجوب الظاهري الذي يلزمه استحقاق العقاب في الجملة.
فان قلت: عدم الوجوب ليس من الأحكام الشرعية حتى يكون الاستصحاب مثبتاً له في الظاهر.
قلت: المثبت بالاستصحاب: كل أمر يكون إبقاؤه ورفعه بيد الشارع - سواء سمّي ذلك حكماً اصطلاحياً أو لا - ولا ريب أنّ عدم الوجوب من الامور المذكورة وليس للعقل مدخل في إثباته ونفيه في الواقع.
____________________
(١) منع (ظ).
والحاصل: أنّ الاستصحاب في الموضوعات فائدته: إثبات الآثار الشرعية التي ثبتت لتلك الموضوعات، وفي الأحكام وما يشبهها فائدته: إثبات نفس ذلك الشيء بحسب الظاهر، ويترتّب على ذلك: لازمه العقلي من استحقاق العقاب وعدمه، والمثبت هنا بالأصل هو عدم الوجوب في الظاهر، ويلزمه عدم العقاب على الترك عقلاً، ولو كان الوجوب ثابتاً في الواقع، كما لو دلّ دليل آخر من الأدلّة الشرعية على عدم الوجوب ولا دليل يقتضي اختصاص أدلة الاستصحاب بخصوص الموضوعات والأحكام ويقتضي خروج مثل عدم الوجوب وعدم الحرمة وما أشبهها من تلك الأدلّة.احتجّ القائلون بوجوب الاحتياط بامور:
الأوّل: قاعدة الاشتغال الجارية في الشبهة المحصورة.
وقد مرّ جوابها في الدليل العقلي على البراءة.
الثاني: استصحاب الاشتغال بعد الاتيان بالأقلّ وقضيّته وجوب الاتيان بالأكثر.
وفيه: أنّه إن قصد بذلك إستصحاب حكم العقل بوجوب تحصيل البراءة اليقينية حتى يحصل اليقين بفراغ الذمة.
ففيه: انّه لا مجرى للشك في حكم العقل حتى يحتاج فى إثباته إلى الاستصحاب، ضرورة أنّ الحاكم لا يشكّ في حكمه، وإن قصد بذلك إستصحاب بقاء الوجوب وبعبارة اخرى استصحاب عدم سقوط ذلك الخطاب الثابت أوّلاً، ففيه (أوّلاً) أنّه مع حكم العقل بوجوب الاحتياط عند الشك في السقوط كما يدّعيه هذا القائل لا وجه للاستصحاب، إذ معنى الاستصحاب: إدراج الوجوب المشكوك تحت عنوان الوجوب المعلوم ظاهراً وتنزيله منزلة ذلك في اجراء احكامه عليه، وهذا انّما يصحّ إذا كان حكمه مخصوصاً بالوجوب المعلوم، وأمّا لو فرضنا أنّ الحكم المقصود إثباته لا يكون من لوازم المعلوم الخاصة به بل يكون لازماً للمشكوك أيضاً فلا يكون هذا الحكم الاّ لغواً وقبيحاً، ونظير ذلك إستصحاب عدم الوجوب، والبراءة الاصلية عند من يرى حكومة العقل بالبراءة
عند الشك.
نعم لو كان التمسّك بالاستصحابين في كل من المقامين - مع قطع النظر عن حكومة العقل بالبراءة والاحتياط - كان وجيهاً ولعلّه كذلك كما أشرنا إليه.
(وثانياً) أنّ وجوب الاكثر لا يكون من اللوازم الشرعية لعدم سقوط الأمر المردّد بين الأقل والاكثر حتى يكون إثباته بالأصل راجعاً إلى إثباته المشكوك، بل هو من لوازمه العقلية بعد فرض أنّ الأقلّ لا يكون موجباً للسقوط.
والحاصل: أنّ عدم سقوط الأمر في الواقع ليس من لوازمه وجوب الاكثر، نعم يلزمه عقلاً ذلك على تقديرأنّ الأقلّ لا يكون مسقطاً، ولا ريب أنّ الاستصحاب لا يثبت إلاّ الآثار الشرعية.
فان قلت: يكفي في المقام إستصحاب عدم السقوط وبقاء الوجوب ظاهراً، ولا يحتاج إلى إثبات وجوب الأكثر حتى يرد ما ذكرت، لأنّ العقل بعد القطع بأنّ الأمر باق يحكم بأنّه يجب اسقاطه، ولا ريب أن طريق اسقاطه إذا كان بعد الاتيان بالأقل لا يكون إلاّ بالاتيان بالاكثر، وهذا نظير إثبات عدم الوجوب ظاهراً باستصحاب عدم وجوب الاكثر الذي أشرنا إليه سابقاً.
قلت: الوجوب الذي لا نعلم له متعلّقاً - لا إجمالاً ولا تفصيلاً - لا يجب امتثاله بالضرورة، فما لم يثبت متعلّق هذا الوجوب الظاهري الذي يثبت بالاستصحاب ولو بين الأمرين لا يجب امتثاله، وكون متعلّقه هو الأقلّ لا يعقل، إذ المفروض أنّ الواقع لو كان هو وجوب الأقل يكون ساقطاً، مع انّه لو كان، لا يفيد وجوب الأكثر وليس متعلّقه الأكثر إذ ليس الواقع المعلوم معلوماً كون متعلّقه الاكثر حتى يكون بالاستصحاب عند الشك يثبت وجوبه وإلاّ لم يكن شك في عدم سقوط الخطاب، والوجوب المطلق ليس من لوازمه الشرعية تعلّقه بالأكثر بعد عدم تعلّقه بالأقل.
ثم إنّ استصحاب وجوب الامر المردّد على تقدير كون الاصل المثبت حجّة لا يصحّ التمسّك به هنا، لأنّ الشك في بقاء الوجوب وعدمه ناش من الشك في كون متعلقه الأكثر أو الأقل ولا ريب أنّ استصحاب عدم وجوب الزائد مثبت لوجوب الأقل وهو مقدّم على هذا
الاستصحاب، لأنّ الأصل في الشك السببي مقدّم على الأصل الجاري في المسبّب، ولو فرضنا عدم التقدّم فيتعارضان والمرجع حينئذٍ أصالة البراءة. وأمّا إبطال إستصحاب الوجوب - بناء على حجّية الأصل المثبت- بأصالة البراءة فلا وجه له، لأنّ الاستصحاب دليل - بناء عليه - على وجوب الأكثر، فلا يكون مجرى لأصالة البراءة فيه لأنّ أصالة البراءة يجري عند الشك وإستصحاب الوجوب رافع للشك ودليل على وجوب الأكثر.
والقول بأن استصحاب الوجوب انّما يصح عند الشك فيه والشك فيه انّما يوجد بعد الاشتغال بالأقل واتمامه ونحن قبل الاشتغال به أثبتنا عدم وجوب الاكثر بأصالة البراءة فلا يبقى لنا شك.
مدفوع بأنّ وجود الشك في سقوط الواقع معلوم، وجريان الاستصحاب حينئذٍ مانع عن حكم العقل بالبراءة، إمّا لفرض زمان الشك قبل الاشتغال بالأقلّ، أو لأنّ العلم بجريان الاستصحاب عند الحاجة إلى الدليل في وجوب الزائد وعدمه، وهو بعد الفراغ عن الأقل مانع عن جريان أصالة البراءة قبل الاشتغال بالأقل.
والحاصل انا نعلم قبل الاشتغال بالأقل انّ الدليل الشرعي على وجوب الزائد في وقت العمل موجود ومع هذا العلم لا معنى لأصالة البراءة كما لا يخفى.
ومن الاصول التي يتمسّك بها لعدم وجوب الأكثر: أصالة عدم الزائد.
وفيه: أنّ المقصود به إمّا أصالة عدم وجوبه العرضي الذي هو عين وجوب الاكثر، أو أصالة عدم لزومه الذي بمعنى اللابديّة الراجع حقيقة إلى أصالة عدم التوقّف، أو أصالة عدم وجوبه الغيري - وعلى أيّ تقدير - لا معنى لاستصحابه.
أمّا الأوّل: فلمعارضته بأصالة عدم وجوب الأقل.
وأمّا الثاني: فلكونه من الاصول المثبتة ، لأنّ من لوازم التوقّف واللابديّة واللزوم العقلي ليس وجوب الزائد شرعاً، بل هو من لوازمه العقلية، فانّ وجوب ما يتوقّف عليه الشيء لا يكون من اللوازم الشرعية للتوقّف واللابديّة، وليس من الآثار المحمولة عليهما مثل إرث زيد الذي موضوعه حياته.
وقد يقال(١) في منع استصحاب اللزوم: بأنّه ليس اللزوم حادثاً مغايراً.
وفيه: أنّ عدم كونه أمراً متأصّلاً لا يوجب عدم صحة استصحابه، لعدم كونه أمراً موجوداً في مرتبة نفسه.
والحاصل: أنّ كونه أمراً انتزاعياً من تعلّق الأمر بالكل لا مانع من جريان الاستصحاب فيه وأنّ وجوب الاكثر يحدث بسببه أمر وهو كون الزائد لازم الاتيان فيستصحب عدمه عند الشك وكونه أمراً انتزاعياً من الأمر لا يوجب عدم استصحاب عدمه.
وأمّا الثالث: فلأنّه أيضاً مثبت إن اريد به إثبات وجوب الأقل كما لا يخفى.
نعم يصحّ إستصحابه إن اريد به إثبات عدم الوجوب ظاهراً الذي يستلزمه عدم إستحقاق العقاب على تركه، وإن كان واجباً في الواقع ومرّ في إستصحاب عدم وجوب الأكثر.
وقد يستدلّ أيضاً بأصالة عدم جزئية الشيء الزائد للمركّب المأمور به.
وفيه: أنّ كونه للمركّب جزء مشكوك من حين حدوثه فلا يقين حتى يستصحب، إلاّ أن يراد به إستصحاب عدم جزئية الشيء المشكوك السابق على وجود المركّب.
وفيه: أنّه حينئذٍ أصل مثبت، لأنّ وجوب الأقل ليس من لوازمه الشرعية.
والحاصل: انّه إن لاحظ جزئية الشيء المشكوك من أوصاف المركّب واستصحب عدمه، يرد عليه: أنّ خلوّ المركّب عن هذا الوصف من أوّل الأمر مشكوك، وإن لاحظ وصفاً لمشكوك وقال: إنّ هذا العدم كان محقّقاً قبل تركّب المركّب وتعلق الأمر فنستصحبه، ففيه: أنّه أصل مثبت، وإن اريد أصالة عدم كونه ملحوظاً عند تركّب المركّب، بناء على أنّ المراد من الجزئية ليس هو كونه مأموراً به في ضمن الكل.
وبعبارة اخرى: ليس المراد أمراً إنتزاعياً من تعلّق الأمر بالكل، بل المراد منه: ملاحظة هذا الشيء مع غيره واحداً، لأنّ جزئية الشيء ليس إلاّ إعتباره مع غيره واحداً.
____________________
(١) القائل هو الأنصاري -قدسسره - في فرائده: ص ٤٦٩.
فنقول: الأصل عدم ملاحظته عند جعل المركّب الذي هو عبارة عن جعل امور متعدّدة أمراً واحداً، وحينئذٍ ملاحظته معلوم وعدم ملاحظة الزائد يثبت بالأصل فيثبت المركّب المأمور به، لأنّ كون المركّب هو الأقلّ يحتاج(١) إلى جنس وجودي هو الأجزاء الخاصة أعني الأقل، وإلى فصل عدمي وهو عدم ملاحظة غير تلك الأجزاء معها، والأوّل مفروض الوجود، والثاني يثبت بالأصل، فيرد عليه أنّ ذلك أيضاً أصل مثبت، إذ ليس من لوازمه الشرعية تعلّق الأمر بالأقل.
وقد يورد عليه بأنّ جزئيّة الجزء وكليّة الكلّ أمران اعتباريان منشؤهما أمر واحد، فأصالة عدم الجزئيّة ترجع إلى أصالة عدم كلية الاكثر، وهو معارض بأصالة عدم كلية الأقل.
ويرد عليه: أنّ ملاحظة الأقل عند اعتبار الوحدة غير الكلية: فانّها عبارة عن اعتبار الوحدة، ونحن نقول: إنّ الاصل عدم الملاحظة عند اعتبار الامور المتعددة أمراً واحداً، فلا يكون هذا تعييناً لأحد الحادثين بالأصل.
مسألة
إذا كان الشك في الجزئية ناشئاً من إجمال الدليل، كما إذا علّق الوجوب في الخطاب اللفظي بلفظ مردّد بين الأقل والأكثر فالحكم فيه كالسابق من حيث جريان البراءة والاحتياط، وهذا الاجمال قد يكون في المعنى العرفي، كما إذا علمنا أنّ الواجب عند الغسل غسل ظاهر البدن، وشككنا في أنّ باطن الأذن أو عكرة البدن من الأوّل أو الثاني، وقد يكون في المعنى الشرعي كالأوامر المتعلّقة بالعبادة في الكتاب والسنّة - بناء على أنّ ألفاظها موضوعة للماهية الصحيحة الجامعة للشرائط والأجزاء - وقد يفرّق بين هذه والمسألة السابقة فيقال: بجريان البراءة هناك لا هنا، استناداً إلى أنّ الخطاب التفصيلي المتعلق بالأمر المجمل المردّد بين الأقل
____________________
(١) ينحلّ (خ).
والأكثر معلوم، ومعه يجب الاحتياط تحصيلاً للبراءة عن مدلول ذلك الخطاب الذي في ذمّة المكلّف واشتغلت به، وفرّعوا على ذلك جريان البراءة على القول بالأعم وعدمه عند الصحيحي.
وفيه: أنّ وجود هذا الخطاب بالنسبة إلى وجوب الأكثر كعدمه، لأنّه لم يحصل منه بيان بالنسبة إلى وجوب الاكثر، إذ المفروض أنّه مجمل وحيئنذٍ فان بنى على أنّ العقل يحكم بالبراءة في الشك في جوب الزائد، وإنّ مثل قولهعليهالسلام : « ما حجب اللّه علمه »(١) شامل للشك في الجزء والشرط، كان المتعيّن البراءة وإلاّ فلا.
فظهر أنّ مناط الحكم بالبراءة - وهو عدم البيان بالنسبة إلى الزائد مع عدم كون الاصل فيه معارضاً لمثله - موجود هنا، فدعوى الفرق لا وجه له. وأمّا الأقل فلما علم بوجوبه على أحد الوجهين - أعني وجوبه الغيري أو النفسي - لا محيص عن الاتيان به إذا لحجّة بالنسبة إليه تامة، وليس بعد البيان مؤمّن عقلي أو نقلي عن استحقاق العقاب على تركه، وإن لم يكن ذلك أيضاً قطعياً - بناء على أنّ المتجرّي لا يعاقب - لأنّ ترك الأقل على تقدير(٢) وجوب الأكثر في الواقع لا يترتّب عليه عقاب إذا بنينا على أنّ الاكثر لا يكون في الظاهر واجباً كما سيتضح إن شاء اللّه.
ودعوى: أن مدلول لفظ الصلاة المردّد بين الأقل والأكثر ثبت وجوبه فيجب الاحتياط.
يدفعها: أنّ الخطاب لم يكن وارداً على مفهوم مدلول الصلاة حتى يكون هو المكلّف به، ويكون إتيان الاكثر محصّلاً قطعياً له، بل الخطاب وارد على مصداق هذا العنوان، لا من حيث كونه مصداقاً بل لذاته، وهو إذا تردّد بين الأقل والأكثر يكون التكليف بالاكثر مشكوكاً، ولا يكون عنوان المكلّف به أيضاً معلوماً حتى يكون ذلك واجب التحصيل.
____________________
(١) التوحيد: ص ٤١٣ ح ٩.
(٢) بناء (خ).
وأمّا ما توهّم من كون جريان البراءة وعدمه ثمرة بين القولين السابقين.
فقد عرفت وهنه، وأنّ الأصل على الصحيح جارٍ عند من يبني في هذه المسألة على البراءة ولعلّ مدّعي الثمرة أيضاً إنّما ادّعاه بناء على اختياره الاحتياط في هذه المسألة، وأمّا ترك الاحتياط على الأعم فان كان لأجل أنّ عنوان المكلّف به غير معلوم، ففيه: أنّ المكلّف به على القولين ليس الاّ الصحيح ولا مدخل بوضع الألفاظ على أحد الأمرين في ذلك.
والحاصل: أنّ المراد من الخطاب ان كان عنواناً للمكلّف به لم يكن معه فرق بينهما في وجوب الاحتياط، وإن لم يكن عنواناً كما هو واضح فلا فرق أيضاً في جريان البراءة، وإن كان لأجل متعلق الخطاب مطلق يشمل الفاقد للجزء المشكوك وواجده، وإطلاقه معنىً ما لم يعلم التقييد، فيجب العمل به.
ففيه أنّ اعتبار الاطلاق فرع كون الخطاب المطلق وارداً في مقام البيان، والأوامر المتعلّقة بالعبادات في الكتاب والسنّة ليست في مقام بيان كيفية ما هو المطلوب(١) ، وانما هي تأكيدات صدرت لبعث المكلّفين على الطاعة، نظير قوله تعالى: (اطيعوا اللّه واطيعوا الرسول)(٢) وقول الطبيب في شرب الدواء، إمّا قبل البيانمشيراً إلى ما يفصّله، أو بعده مشيراً إلى ما فصّله، كما هو الغالب، وكيف كان فدعوى الثمرة بين القولين بما ذكر لا وجه له.
مسألة
إذا كان الشك في الجزئية ناشئاً عن تعارض النصين الدالّ أحدهما على الجزئية والآخر على العدم، فالظاهر أنّ الاكثر بناؤهم هنا على التخيير.
والتحقيق: أنّه إمّا أن يكون هنا اطلاق يدفع به الشك لولا الدليل، أو لا يكون فان لم يكن هناك اطلاق، فان بني على ترجيح أحد المتعارضين، بالأصل، أو قيل
____________________
(١) المطلق المطلوب (خ).
(٢) محمّد: ٣٣.
فيهما مع عدم المرجّح بالتساقط، وأنّ الاصل هو المرجع فالحكم هنا كالحكم في السابق من حيث جريان البراءة والاحتياط، وإن لم نقل بشيء منهما وقيل بالتخيير فالواجب هو الحكم بالتخيير، وإن كان هناك اطلاق فان قلنا: إنّ اعتبار أصالة الاطلاق من باب الظهور النوعي فالظاهر ترجيح نافي الجزئية.
ولا يتوهم: أنّ الظهور النوعي اعتباره مبني على عدم وجود ظن خاص على خلافه، فلا يكون مع وجود مثبت الجزئية مرجعاً، لأن الترجيح انّما هو من جهة الظن بمطابقة مدلول أحد المتعارضين للواقع، والظهور النوعي إذا اقترن بأحد المتعارضين يفيد ذلك وإن لم يكن معتبراً فتأمّل. وليس الأمر في الأصل كذلك بناء على اعتباره تعبّداً، إذ ليس له حينئذٍ كشف عن الواقع بالمرّة، وإن قلنا بأنّ اعتباره أيضاً من باب التعبّد كاعتبار سائر الاصول التعبّدية، فان قلنا بأنّ أخبار التخيير شاملة لما إذا كان هناك دليل إجتهادي مطابق لمدلول أحد الأمارتين، فالظاهر هو البناء على التخيير، وإن قلنا بأنّ الاخبار المذكورة منصرفة إلى غير هذه الصورة، فيجب العمل حينئذٍ بمقتضى الاطلاق.
ومنشأ الاحتمالين تردّد أخبار التخيير بين أن يكون المراد منها: بيان أنّه عند التعارض لا يجوز طرح الأمارتين والرجوع إلى الاصول العقلية أو النقلية الثابتة علاجاً للمتردّد وانّ المتردّد في الحكم حينئذٍ يجب عليه العمل على طبق أحد الأمارتين، فيكون حكماً عمليّاً لمن لم يكن له حجّة معتبرة من الشرع من الأدلة الاجتهادية كالمطلقات والعمومات، وبين أن يكون المراد منها: حجيّة أحد المتعارضين.
فان قلنا بالأوّل وجب العمل بمقتضى الاطلاق، لأنّ أصالة عدم التقييد مثبت لحجّيته، وليس أصلاً عملياً تعبّدياً أو عقلياً حتى يكون أدلّة التخيير رافعاً لاعتباره، إذ المفروض أنّها على الأوّل ناظرة إلى المنع عن العمل بالاصول الموضوعة علاجاً لعمل المتردّد في الحكم لأجل عدم الدليل الاجتهادي.
وإن قلنا بالثاني كان الواجب هو الأخذ بأحد الخبرين، وإن كان مقتضى
المختار هو مقتضى الاطلاق، لكنّ الأخذ به حينئذٍ ليس من باب اعتبار الاطلاق، بل لحجية الأمارة، وذلك لأنّ أصل الاطلاق وإن كان غايته العلم بالتقييد، يكون أدلّة حجّية الأمارات حاكمة عليه، لأنّها تفيد كون الأمارات منزّلة منزلة العلم، فكلّ ما كان غايته العلم، يكون الأمارة المنافية لمدلوله بل الموافقة لمدلوله حاكمة عليه، إذ المفروض كون تلك الأمارة منزّلة منزلة العلم، فيكون رافعاً لأصل الشك، فلا يبقى معه للأصل موضوع وتمام الكلام في باب التراجيح إن شاء اللّه تعالى.
مسألة
إذا كان الشك في الجزئية ناشئاً من الشبهة في الموضوة الخارجي، كما إذا كان المأمور به مفهوماً مبيّناً يكون مصداقه مردّداً بين الأقل والأكثر، كما إذا علمنا بأنّ صوم شهر هلالي واجب، وشككنا من جهة الشك في الرؤية أنّه ثلاثون يوماً أو أقل، وكما إذا علمنا أنّ الواجب عند الصلاة هو الوضوء الرافع للحدث، وشككنا في أنّ الأمر الفلاني جزء للوضوء أم لا، فالظاهر هنا وجوب الاحتياط، لأنّ الواجب وهو المفهوم المبيّن معلوم ومع العلم به يكون الذمّة مشغولة به، فيجب تحصيل ما يوجب الفراغ قطعاً وهو ليس الاّ الاكثر، والأدلّة العقلية والنقلية الدالّة على البراءة في المسألة السابقة لا تجري هنا، لأنّ الشك هنا في أنّ المكلّف به هل وجد في الخارج إذا اتي بالأقل أم لم يوجد، وفي مثل هذه الموارد يجب الاحتياط، ولذا لو شك في إتيان شيء من الأجزاء المعلومة لا يحكم العقل حينئذٍ بالبراءة.
والحاصل: أنّ الشك هنا ليس في أنّ الجزء فعل واجب أم لا، بل الشك في أنّ الواجب المعلوم وجوبه هل يحصل في الخارج بالأقل أم لا؟ ولا ريب أنّ شيئاً من أدلة البراءة لا يجري هنا، وفي السابق راجع إلى الشك في أنّ الجزء الزائد هل هو واجب كسائر الأجزاء ام لا يكون واجباً؟ وليس هنا أمر محقّق الوجوب يشك في حصوله في الخارج مع الاكتفاء بالأقلّ حتى نقول بالاحتياط، فظهر الفرق بين المسألتين.
الشك في الشرطية
مسألة
إذا شك في كون شيء قيداً للمأمور به فلا يخلو عن صورتين لأنّ منشأ القيد قد يكون فعلاً خارجياً مغايراً للمقيّد في الوجود الخارجي، كالطهارة بالنسبة إلى العبادة، وقد يكون منشؤه أمراً متّحداً في الوجود الخارجي، كالايمان بالنسبة إلى وجوب عتق الرقبة، ولابدّ من تمهيد مقدّمة وهي أنّ المركّب إمّا أن يكون مركّباً من الامور الخارجية المتغايرة في الوجود الخارجي كالصلاة بالنسبة إلى التكبير، والقراءة، وغيرها من الأفعال المستقلّة، وقد يكون مركّباً من الامور التي ليس لوجودها في الخارج تمايز، بمعنى أنّه ليس لكل جزء وجود في الخارج مميّز عن وجود الجزء الآخر، بل الأجزاء في الحقيقة ليس لها في الخارج إلاّ وجود واحد، والجزء المركّب في الأوّل واجب في ضمن الكلّ ويتعلّق به طلب مستقلّ لكنه غيريّ، نظير وجوب المقدّمة وفي المركّب في الثاني ليس له وجوب مستقلّ غير وجوب الكلّ، لأنّ الوجوب الغيري مفروضه ما يتوقّف على وجوده وجود الواجب، فهو فرع تعدّد الوجود، ولا ريب أنّ الاجزاء العقلية ليس لها وجود غير وجود الكلّ فتأمّل، وأمّا الوجوب العرضي فهو ليس وجوباً مستقلاً، بل هو عين وجوب الكل ينسب إلى الأجزاء بالعرض والمجاز.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ القائل بأنّ الأصل في الشك في القيد هو البراءة: إن قال انّ المطلق معلوم الوجوب ووجوب القيد مشكوك، والعقل يقتضي البراءة عند الشك. فجوابه: أنّ المطلق ليس متيقّن الوجوب، لأنّه إمّا واجب نفسي أو ليس بواجب أصلاً، لأنّه من حيث كونه داخلاً في المقيّد لا يتعلّق به طلب غيري حتى يقال: إنّه سواء كان الواجب هو المطلق أو المقيّد يكون المطلق متيقّن الوجوب والمقيّد مشكوكاً، بل الواجب إمّا المطلق أو المقيّد، وليس في البين ما يكون متيقّن الوجوب، وإن قال: انّ المطلق لمّا كان عين المقيّد في الوجود الخارجي فالوجوب
المضاف إلى المقيّد مضاف إلى المطلق فهو واجب لا محالة، غاية الأمر إنّ وجوبه عين وجوب المقيّد أو يكون مورداً للخطاب مستقلاً.
فجوابه: أنّ العقل لا يحكم بالبراءة إلاّ إذا كان ما تيقّن وجوبه حاصلاً في الخارج على وجه تحصل البراءة القطعية عن ذلك من جهة وجوبه.
وبعبارة اخرى: إنّما يحكم العقل بالبراءة عند الاكتفاء بالأقل إذا كان الأقل صالحاً حين وجوده في الخارج لأن ينضمّ إليه القيد المشكوك، لأنّ تحصيل البراءة عن الواجب الذي ثبت وجوبه من جهة وجوبه على جميع تقاديره لازم، وهو انّما يتحقّق إذا كان المأتي به في الخارج صالحاً لأن ينضمّ إليه القيد، لأنّه مع عدم صلاحيّته لذلك لا يحصل البراءة القطعية من جهته، ضرورة أنّ عتق الكافرة لا يحصل منه البراءة عن وجوب عتق الرقبة الذي مردّد بين وجوب غير وجوب المقيّد وبين وجوب هو عين وجوب المقيّد، بل هو على تقدير كون وجوب المطلق عين وجوب المقيّد لا يحصل به شيء من الواجب.
وبالجملة: حكم العقل بالإكتفاء بالأقل فيما نحن فيه لا يفيد إلاّ مع إيجاد المطلق في ضمن الفرد المباين للمقيّد، ومعه لا يحصل البراءة بالنسبة إلى ما فرض القطع بوجوبه على جميع التقادير، فانّه على تقدير كون الواجب هو المقيّد لا يكون المباين محصّلاً للبراءة عن وجوب المطلق، لأنّ المطلق موصوف بالوجوب من حيث اتّحاده في الوجود مع المقيّد، وإن قال: إنّ المطلق لما كان لازم التحصيل في الخارج، لأنّه إمّا واجب والواجب ما لا يمكن حصوله منفكّاً عنه كان الحجة بالنسبة اليه تامّة، فالشك في وجوبه لا يكون مجرى للأصل، والمقيّد لما كان مشكوك الوجوب ولم يكن مثل المطلق محكوماً بحكم العقل بلزوم الاتيان كان الأصل فيه البراءة. والفرق بين هذا التقرير وسابقه: أن جريان الأصل مبنيّ على القطع بوجوب الأقل شرعاً بخلافه هنا وهذا التقرير جار في المسائل السابقة بناءً على القول بعدم وجوب المقدّمة، ضرورة أنّ الأقل لا يكون حينئذٍ متيقّن الوجوب شرعاً فلا يتم التقرير المذكور، فالجواب عنه هو الجواب عن التقرير الثاني، من أنّ
ذلك يتمّ فيما إذا كان الأقلّ الموجود في الخارج قابلاً لانضمام القيد به حتى يكون ما حكم بلزومه حاصلاً على جميع التقاديرلزومه وبدونه لا يحكم بذلك.
ويمكن تقرير حكم العقل بالبراءة على وجه لا يرد عليه ما مرّ بأن يقال: إنّ المطلق الموجود في ضمن الكافرة عين الموجود في ضمن المؤمنة وحينئذٍ تحصل باتيان الكافرة البراءة عن وجوب المطلق.
وفيه: مع المنع فيه - لامكان دعوى أنّ الطبيعة الموجودة في ضمن الأجزاء ليس الموجود منها في ضمن الفرد إلاّ حصّة مغايرة لحصّة موجودة في الفرد الآخر - أنّ ذلك لا يفيد في حصول البراءة عن وجوب المطلق على جميع تقاديره، إذ وجوبه على تقدير كونه عين وجوب المقيّد انما يحصل البراءة عنه باتيان المقيّد.
ودعوى: أنّ التكليف بالمقيد لاشتماله على كلفة زائدة والزام زائد منفي بالأصل.
قد عرفت الجواب عنه وأنّ ذلك لا يفيد مع عدم كون المطلق متيقّن الوجوب، وتيقّن وجوبه بوجه قررناه في الوجه الثاني لا يمكن معه إجراء الأصل، إذ الفراغ عنه من دون القيد على وجه التيقن غير حاصل، ومعه لا حكم بالبراءة عن الزائدة.
ثم إنّه قد يفرّق بين ما إذا كان القيد منشأ فعل مستقلّ في الخارج فيحكم بالبراءة، بناء على أنّ الشك في القيد راجع إلى الشك في وجوب ذلك الفعل، والأصل عدمه، وبين ما إذا لم يكن كذلك فلا يحكم بها، لأنّ القيد لا يكون متعلّقاً لخطاب مستقلّ، وليس داخلاً في عنوان الواجب حتى يقال: إنّ التكليف به تكليف بدون بيان.
والظاهر أنّه لا وجه للفرق، لأنّ القيد الذي لا يرجع الشك فيه إلى الشك في الفعل، قد يكون على تقدير كونه قيداً مستلزماً لخطاب زائد على الخطاب بالواجب، كما إذا فرض عدم وجود رقبة مؤمنة وتمكّن المكلّف من إرشاد بعض العبيد إلى الإيمان، فانّه يجب ذلك حينئذٍ مقدّمة، وإن كان واجباً في نفسه أيضاً، فنفي هذا التكليف لو كان مثمراً في نفي القيد لم يكن فرق بين المقامين.
والحاصل: أنّ فاقد الشرط كما لا يحصل به البراءة في القسم الثاني كذلك
لا يحصل به في الأوّل، وكما لا يكون المطلق متيقّن الوجوب كذلك لا يكون المطلق هناك متيقّن الوجوب.
والحاصل: أنّ الموانع عن الحكم بالبراءة بأجمعها جارية في القسمين من غير تفاوت، هذا في حكم العقل
وأمّا الأدلّة النقلية
كقولهعليهالسلام : « ما حجب اللّه. »(١) و « رفع. الخ »(٢) و « الناس في سعة »(٣) ، فالظاهر دلالتها على البراءة فيما إذا كان دوران الأمر بين وجوب المطلق والمقيّد عرفاً من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر، إمّا لأنّ المقيّد يعدّ عرفاً مركّباً من أمرين كالصلاة مع الطهارة والصلاة مطلقاً، أو لأنّ المقيّد اخذ في لسان الشارع أمراً مركّباً، مثل رقبة مؤمنة ومطلق الرقبة، فانّه حينئذٍ يصحّ أن يقال: إنّ المطلق معلوم الوجوب، والمقيّد مشكوك فوجوبه محجوب، وغير معلوم، فهو موضوع ومرفوع، والناس في سعة، وإمّا إذا كان المقيّد أمراً مبائناً للمطلق - مثل الانسان والحيوان - فدلالتها على البراءة مشكل، إذ ليس حينئذٍ ما يصدق عليه عرفاً أنّه معلوم الوجوب، بل الوجوب مردّد في تعلّقه بماهيّتين إحداهما أقلّ فرداً من الاخرى، فالاصل بالنسبة إليهما متعارض.
والحاصل: أنّه متى كان وجوب المطلق عرفاً أمراً يقينيّاً، وكان طرف الشك هو خصوص وجوب المقيّد - بحيث لا يمكن أن يقال عرفاً: إنّ الواجب مردّد بين المطلق والمقيّد لكون وجوب الأوّل مفروغاً عنه - كان المقيّد داخلاً تحت الاخبار المذكورة، وأمّا مع كون المطلق والمقيّد يعدّان عرفاً متبائنين - بحيث لا يكون أحدهما مندرجاً في ضمن الآخر - فلا دلالة لها، إذ حينئذٍ كما يدخل المقيد تحتها كذلك المطلق داخل تحتها ويكون الأصل في كل منهما معارضاً بالأصل الخارجي في الآخر، فيجب حينئذٍ طرحهما فتأمّل.
____________________
(١) التوحيد: ص ٤١٣ ح ٩.
(٢) التوحيد: ص ٣٥٣ ح ٢٤.
(٣) المحاسن: ص ٤٥٢ ح ٣٦٥.
مسألة
إذا دار الأمر بين التخيير والتعيين كما لو شك: في أنّ الواجب في كفّارة شهر رمضان خصوص العتق، أو إحدى الخصال الثلاثة، فالظاهر أنّ مقتضى الأصل هو الثاني، إذ ليس لها جامع خارجي أو ذهني يقيني الوجوب حتى يحكم في الزائد بعدم الوجوب، مع أنّك قد عرفت أنّ الجامع الذهني غير كاف في إجراء البراءة، فانّ الجامع بين طرفي الشك ليس إلاّ انتزاعيّاً، وليس هنا جامع محقّق خارجي أو ذهني حتى يحكم فيه بالوجوب ويدفع الزائد بالأصل هذا حكم العقل، وأمّا الأخبار فالظاهر أيضاً عدم شمولها، لما مرّ من أنّ الجامع الذهني - مع عدم كون المركّب عرفاً من المركبات - غير كاف في شمولها، فعدم شمولها لمثل هذه المسألة أولى.
مسألة
الشك في مانعية شيء راجع إلى الشك في شرطية عدمه، فالكلام فيه هو الكلام في شرطية شيء، وأمّا الشك في قاطعيّة شيء للعبادة في الأثناء بعد العلم بأنّه لا مدخل له في العبادة إلاّ من جهة قطعه لهيئة العبادة بمعنى إخراج الأجزاء السابقة عن قابليّة لحوق سائر الأجزاء بها، فالحكم فيه كما يأتي في إستصحاب تلك الهيئة.
مسألة
إذا علم جزئية شيء في الجملة وشك في أنّه جزء مطلقاً حتى أنّه لو ترك سهواً فسد المأمور به، أو هو جزء في غير حال السهو حتى يكون تركه سهواً غير موجب لفساد العبادة ؟ فقد يقال(١) : إنّ الأصل عموم الجزئية، وحينئذٍ فإذا انتفى ينتفي
____________________
(١) القائل هو الأنصاري -قدسسره - في فرائده: ص ٤٨٣.
المركّب فيكون فاسداً - أي غير مطابق للمأمور به - فلا يكون مسقطاً للأمر، وذلك لأنّ الغفلة لا يكون موجباً لتغير المأمور به، وذلك لأنّ المخاطب بمركّب إذا غفل عن جزء لا يتغيّر الأمر المتوجّه إليه، ولا يحدث أمر آخر متوجهاً إليه، إذ الغافل غافل عن غفلته فلا يمكن توجيه الأمر إليه، بل لا فائدة في الأمر بحسب نفس الأمر ولو لم يكن متوجّهاً إليه، لأنّ الفائدة التي يتصوّر صدور الأمر لأجلها هي بعث المكلّف على العمل، والغافل غير قابل للالتفات إلى الأمر المتوجه إليه - بعنوان كونه غافلاً - لأنّه متى إلتفت إلى ذلك الأمر يلتفت إلى كونه غافلاً عن الجزء فيلتفت إلى الجزء فلا يبقى غافلاً حتى يعمل بمقتضى ذلك الأمر.
وبالجملة: الغافل إمّا أن يكون في الواقع مكلّفاً بما يكون الملتفت به مكلّفاً أو يكون مكلّفاً بما عدا ذلك الجزء المغفول عنه، أو لا يكون مكلّفاً، لا سبيل إلى الأخيرين، لأنّ خطابه بما عدا الجزء المنسي لا يمكن، لأنّه غافل عن غفلته، والمفروض انه في الواقع له تكليف، فيتعيّن أن يكون هو ما كلف به الملتفت، ولو فرض إنّه غير مكلّف في الواقع بشيء، فعدم اقتضاء ما فعله في حال النسيان والغفلة لسقوط الأمر المتوجّه إليه في حال الالتفات ظاهر، فبعد الالتفات يجب عليه إثبات المأمور به، ومن هنا علم أنّ عموم الجزئية لحال النسيان لا حاجة في إثباته إلى اطلاق دليل الجزئية أو عمومه، مثل كون الدليل نظير قولهعليهالسلام : لا صلاة الاّ بفاتحة الكتاب(١) وأمثاله، بل كلّما ثبت الجزئية في حال الالتفات ثبت في حال الغفلة إلاّ أن يثبت من الخارج دليل على أنّ ما فعل في حال الغفلة يكون مجزياً، والشك في ثبوت دليل يقتضي ذلك يعمل فيه بمقتضى أصالة عدم ذلك، وأصالة البراءة عن التكليف بالجزء في حال الغفلة لا يوجب الاّ نفي العقاب على ترك الجزء وهو ثابت سواء كان جزئيته عامة لصورة السهو أو يكون خاصة بصورة الالتفات، ولا يقتضي الاجزاء حتى يقال: إنّ مقتضاها سقوط الأمر الأوّل. هذا.
____________________
(١) عوالي اللئالي: ج ١ ص ١٩٦ ح ٢.
ويمكن أن يقال: بامكان اختصاص الجزء بحال العمد، فانّ السهو عن الجزء قد يكون لأجل عدم الالتفات إلى مفهوم الجزء، وهو يستلزم عدم الالتفات إلى جزئيّته ضرورة أنّ الالتفات إلى جزئية شيء يستلزم الالتفات إلى ذلك فمتى انتفى الالتفات إليه انتفى الالتفات إلى الجزئية.
وقد يكون لأجل عدم الالتفات إلى الجزئية مع الالتفات إلى مفهوم الجزء، والتخصيص في الصورة الاولى يمكن بوجوه ثلاثة لا يستلزم شيء منها ما ذكرنا من المانع:
الوجه الأوّل: أن يوجّه المكلّف إلى عامّة المكلّفين خطاباً مطلقاً، ثم يوجّه الأمر بالجزئية إلى كل من يكون ملتفتاً إلى مفهوم ذلك الجزء في ذلك المحلّ الذي يريد إتيان الجزء فيه - كأن يقول مثلاً بعد الأمر بمطلق الصلاة أنّ الركوع واجب مثلاً على من يكون ملتفتاً إلى مفهومه بعد الفراغ عن السورة وقبل الدخول في السجود وحينئذٍ يكون ما أتى به الذي لم يلتفت إليه مطابقاً للأمر مع الالتفات إليه، إذ المفروض ثبوت الأمر المطلق الشامل لما يكون مع الركوع وما لا يكون معه، ولا يلزم من الالتفات إلى الأمر التفات إلى الغفلة حتى لا يمكن توجيهه إليه ليعمل بمقتضاه، لأنّه لا يكون الغافل بعنوان الغفلة موضوعاً للأمر بما عدا الركوع ليستلزم الالتفات إلى عنوان الأمر للالتفات إلى حاله - أعني كونه غافلاً -.
الوجه الثاني: أن يعتبر الشارع في عنوان التكليف أمراً ملازماً في الخارج لنسيان الجزء، ولا يكون تصوّره موجباً للالتفات إلى النسيان ويجعل المأمور به باقي الاجزاء لا بهذا العنوان حتى يوجب الالتفات إلى المنسيّ، بل بعناوينها الواقعيّة - كأن يقول: من كان رطوبته كثيرة يجب عليه فعل يشتمل على التكبير والقراءة والسجود ويعدّ باقي الأجزاء ويسقط الركوع من بينها - ضرورة أنّ الأمر بسائر الأجزاء إنما يوجب توجهه إلى الناسي الالتفات إلى النسيان إذا اخذ عنوان النسيان عنواناً للمكلّف، أو جعل المأمور به فعل باقي الاجزاء بهذا العنوان، ومتى لم يكن الأمر كذلك لم يوجب الأمر الالتفات.
وهذا الوجه كما ترى يمكن مع الغفلة عن الجزئية والإلتفات إلى مفهوم الجزء ولا محذور فيه.
الوجه الثالث: أن يأمر الملتفت إلى مفهوم الجزء باتيانه في محلّه ولا يأمر الغافل حين الغفلة بسائر الأجزاء لا بعنوان عام يشمل الملتفت، كما التزمنا به في الوجه الأوّل، ولا بعنوان يخصّ به، كما مرّ في الوجه الثاني، بل يكتفي بمجرّد صدور الفعل منه حين الغفلة، ولا يوجّه إليه الأمر لحصول الغرض المقصود من توجيه الأمر وهو البعث على الفعل بقصد الاطاعة.
والحاصل: أنّه يجوز أن يكون الخطاب بالجزء مخصوصاً بالملتفت ولا يوجّه المكلّف إلى الناسي أمراً مع كون صدور غير الجزء المنسي عنه محبوباً لأجل حصول الغرض الباعث على الأمر وهو بعث المكلّف على العمل بقصد الطاعة إذ المفروض حصول ذلك من الناسي، ومجرّد المحبوبيّة كافٍ في استحقاق الثواب على الفعل، وكافٍ في صحّة قصد التقرّب، بل لو فرض العلم بالمحبوبية من غير جهة الخطاب لوجب عليه العمل بالمحبوب ولجاز عقابه على تركه.
ويمكن التخصيص في الصورة الثانية أعني نسيان الجزئية من غير نسيان مفهوم الجزء بأن يوجّه أوّلاً إلى عامة المكلّفين خطاباً بسائر الأجزاء ثم يوجّه أمراً بذاك الجزء من غير أن يخصّه بالملتفت ليستلزم الدور ويقال: إنّ الملتفت إلى الجزئية لا يكون كذلك إلاّ بعد جعل الجزئية فلا يمكن أخذ الالتفات إليها في خطاب الجاعل لها، ولكن يكون ذلك الخطاب العام توطئة لأجل خطاب آخر موضوعه: العالم بالخطاب الأوّل كأن يقول: من كان ملتفتاً إلى الأمر بالسورة مثلاً يطلب منه السورة، ومن لا يكون لا يطلب منه، ويكون الخطاب الثاني كاشفاً عن الخطاب الأوّل ومبيّناً للمراد منه، وحينئذٍ يكون فعل ناسي الجزئية مطابقاً للأمر لوجوده بعنوان عام يشمله وغيره.
غاية الأمر انّه لم يبق المأمور به على إطلاقه بالنسبة إلى الملتفت وقيّد بالمشتمل على الجزء الذي نسيه الناسي وإطلاقه بالنسبة إلى الناسي باق، ولا يستلزم
الالتفات إلى هذا الأمر العام، الالتفات إلى جزئية الجزء المنسي، كما مرّ في الوجه الأوّل إذا عرفت هذا.
فنقول: إذا أمكن تخصيص الجزئية بحال الالتفات، فلو شككنا في جزء أنّه هل يكون مخصوصاً بأحد الوجوه السابقة بالمتلفت أو تعم حالتي الالتفات والسهو؟ فمقتضى القاعدة عدم ايجاب الإعادة والقضاء على الناسي بعد الالتفات، لأنّ وجوب الاعادة فرع العلم بكون الحكم الواقعي في حقّ الناسي وغيره واحداً حتى يجب تحصيل البراءة منه حتى حال الشك في سقوطه وهو في المقام غير معلوم، لأنّ المعلوم ثبوته في مثل هذا الحال ثبوت تكليف متعلق بتمام الأجزاء في حال الالتفات بغير الجزء المنسي في حال النسيان، وليس دليل على أنّ تكليف الناسي في الواقع هو تمام الاجزاء حتى الجزء المنسي حتى يقال: ان الحكم بالاجزاء موقوف على دليل اكتفاء الشارع في حال البيان عن مطلوبه الواقعي بما أتى المكلّف به في حال النسيان، وحيث لا دليل على سقوط الأمر، يجب اسقاطه بالاعادة وتدارك ما فات في الوقت بعده.
وبالجملة: ثبوت الاعادة في الوقت والقضاء في خارجه موقوف على كون المكلّف به في حال النسيان هو المكلّف به في حال الالتفات حتى يكون الشك في سقوطه كافياً في ايجاب الاعادة والقضاء ويحتاج في الحكم بعدم وجوبهما إلى دليل يقتضي بدليّة الفعل الصادر نسياناً عن المأمور به الواقعي، ومع الشك في ذلك واحتمال كون الحكم الواقعي أحد الأمرين وجوب فعل تمام الأجزاء في حال الالتفات، ووجوب باقي الأجزاء في حال النسيان فالقدر الذي ثبت التكليف اليقيني به هو ذلك وهو يسقط بفعل المنسي بداهة والتكليف، بما عداه غير معلوم حتى يجب بمقتضاه الاعادة في الوقت ويصدق مع عدم موافقته فوت الواجب حتى يجب القضاء في خارج الوقت، ومع عدم الثبوت يكون الأصل براءة الذمة عن وجوب الاعادة والقضاء.
والحاصل: أنّ سقوط الأمر بما علم تعلّق الأمر به بفعل الناسي في حال النسيان
معلوم، وثبوت التكليف بغيره غير معلوم بعد زوال النسيان لا دليل على الاعادة سواء كان الوقت أم لا.
وقد يقال: إنّ عموم حديث الرفع - بناء على أن يكون المرفوع تمام آثار المنسي - يقتضي البراءة، لأنّ الجزئية من آثار الجزء المنسي فهي مرفوعة بمقتضى الخبر في حال النسيان.
وفيه: بعد تسليم أنّ المقصود رفع جميع الآثار أنّ الجزئية ليست من الآثار الشرعية القابلة للابقاء والرفع حتى يقال: انّ الحديث دالّ على رفعها، لأنّها لا تكون الاّ انتزاعياً من الأمر بالكل وليست أمراً مجعولاً شرعياً يكون قابلاً للبقاء والرفع، والقابل لهما انّما هو الأمر بالكل الذي يكون منشأ لانتزاع ذلك، وهو ليست من آثار الجزء المنسي وفساد العبادة التي ترك فيها الجزء وإن كان مستنداً إلى ترك ذلك الجزء، إلاّ أنّه ليست ايضاً حكماً شرعياً للجزء، بل من اللوازم العقلية للأمر بالكل، إذ فساده ليست الاّ عدم موافقة العبادة للأمر الأوّل واستناد بقاء الأمر الأوّل إلى ترك الكل المستند إلى ترك الجزء في ضمن ما أتى به من العبادة لا يجعل البقاء من آثار ترك الجزء إلاّ بواسطة وهي كونه مستلزماً لترك الكل فلا يكون بقاء الأمر الأوّل بسبب ترك الجزء من أحكام الجزء حقيقة، بل هو من اللوازم العقلية لتركه، والمرفوع في الرواية آثار المنسي بلا واسطة، لأنّ الآثار التي لها بواسطة، حقيقة آثار للواسطة، والمرفوع في الرواية الآثار الشرعية الثابتة للمنسي بلا واسطة، وليست الجزئية منها، كما أنّ بقاء الأمر الأوّل ليس أيضاً منها.
ويمكن دفع هذا الاشكال بوجهين:
الأوّل: أنّ الجزئية وإن كانت أمراً انتزاعياً، إلاّ أنّها مجعولة للشارع بالتبع - أي بجعله الأمر بالكل - وكما يكون المجعول أصالة داخلاً في المرفوع، كذلك المجعول تبعاً داخل فيه وتوضيح ذلك أنّه لا شبهة أنّ الجزئية من الأحكام الوضعية الثابتة للجزء فإن لم يكن مجعولاً أصالة، لكنه مجعول تبعاً بسبب جعل ما انتزع منه من الأمر أو النهي مثلاً ولا ريب أنّ رفع ذلك وإبقاءه برفع منشأ إنتزاعه وإبقائه، فهو وإن لم
يكن قابلاً للرفع في نفسه مع قطع النظر عن منشأ انتزاعه لكنه قابل له برفع منشأ انتزاعه، والمرفوع في الخبر: رفع آثار المنسي، وآثاره أعم من الآثار المجعولة له أصالة والمجعولة له تبعاً، غاية الأمر انّ رفع كل شيء بحسبه، فرفع المجعول أصالة برفع نفسه، ورفع المجعول تبعاً برفع منشأ انتزاعه، وعدم كون منشأ الانتزاع من آثار المنسي لا يضرّ في المقام ولا نقول به، بل الآثار المرفوعة أعمّ من الآثار المجعولة تبعاً وأصالة، وذلك لأنّ المرفوع بواسطة ايضاً مرفوع، فالمانع عن شمول الحديث للجزئية - وهو عدم قابليتها للرفع - غير موجود.
فان قلت: إنّ رفع الجزئية بهذا المعنى - أعني رفع منشأ انتزاعه - لا يوجب الاكتفاء بالفعل الصادر في حال النسيان، ضرورة أنّ عدم الأمر بالكلّ لا يستلزم الأمر بمفهوم آخر مباين له.
قلت: المفهوم من رفع الجزئية عرفاً هو رفع خصوصها مع بقاء الأمر بباقي الاجزاء، مع امكان أن يقال: إنّ رفع الأمر بالكل مع العلم بكون الناسي مكلّفاً بشيء في الواقع يكفينا في المقام، فانّ معه يتعيّن أن يكون باقي الأجزاء هو المأمور به فتأمّل.
الثاني: أنّ معنى الجزء هو أنّ ما صدر نسياناً منزّل منزلة عدمه، فترك السورة نسياناً منزّل منزلة السورة، فيدلّ على الاكتفاء في حال النسيان بما عدا الجزء المنسي.
وحاصله: أنّ الترك والفعل الصادرين عن نسيان مرفوعان - بمعنى أنّه يكون حصولهما كعدم حصولهما -.
وفيه: أنّه لا يفيد في المقام، لأنّ كون ترك السورة منزّلاً منزلة عدمه لازمه العقلي وجود السورة حيث ان ترك ترك الشيء ملازم في الخارج لوجوده، وليس لازمه الشرعي وجود ذلك الشيء، مع أنّا نمنع أنّ معنى رفع الترك الصادر عن نسيان تنزله منزلة عدمه، بل المراد: رفع آثاره لأنّه الظاهر من الكلام، ونمنع كون معناه رفع الترك أو الفعل الصادرين عن نسيان، بل معناه: رفع المنسي وهو ما ترك
نسياناً سواء كان ما ترك فعل شيء مثل السورة، أو ترك شيء كترك التكلّم، ولا ريب أنّ معنى رفع المنسيّ رفع آثاره وهو ترتّب المؤاخذة على تركه أو كونه جزء لعبادة أو شرطاً لها أو غير ذلك من آثاره الثابتة المترتّبة عليه حال الالتفات.
الكلام في الزيادة
مسألة
من الامور التي يمكن الشك في كونها مانعة عن العبادة الزيادة وهي: انّما تتحقّق في الجزء الذي لم يكن مأخوذاً فيها عدم الزيادة، والمراد من الزيادة المعتبر عدمها في الجزء هو عدم لحوق ذات الجزء بمثله لا الزيادة على المركّب، إذ يستحيل إعتبارها في مفهوم الجزء، لأنّ ملاحظة الجزء مقدّمة على ملاحظة المركّب، وملاحظة الزيادة متأخّرة عن تصوّر المركّب، فلا يمكن إعتبارها في مفهوم الجزء، ثم إنّ عدم لحوق ذات الجزء بمثله قد يكون من اعتبارات المركّب بحيث يكون الجزء هو الذات لا بشرط شيء ويكون ذلك من الامور المعتبرة في المركّب، وقد يكون من إعتبارات الجزء بحيث يكون الجزء هو الذات الغير الملحوقة بمثله.
فعلى الأول: يكون المأتي به ثانياً بقصد الجزئية زيادة في المركّب وموجباً لنقصه، لكونه نقيض ما اعتبر فيه ولا يمكن معه إتمام المركّب أيضاً لتحقّق ما اعتبر عدمه.
وعلى الثاني: يكون المأتي به مفسداً لما أتى به أوّلاً بقصد الجزئية لانتفاء شرطه الذي هو عدم لحوق مثله به ويكون زيادة في المركّب إن قلنا إنّه لا يعتبر في تحقّق الزيادة في المركب سنخيّة ما أتى به بقصد الجزئية لبعض أجزائه.
وإن قلنا: إنّه يعتبر ذلك فلا يكون زيادة وهل يمكن بناءً على كون عدم التعدّد من لواحق الجزء تدارك ما فسد باتيان الزائد؟ الظاهر نعم لأنّ الثالث لا يكون ملحوقاً بمثله فهو جامع للشرط المعتبر في الجزء وحينئذٍ لا مانع من صحة المركّب الاّ من حيث الشك في كون السابق مفسداً لكونه زيادة نعم لو كان التعدّد المعتبر
عدمه في الجزء عدم كونه مقروناً بمثله ولو سابقاً عليه لم يمكن تداركه.
واعلم: أنّ في صورة التمكّن من تدارك الجزء لا يمكن قصد كون ما يفسد به السابق جزءً لانّ الأمر بذات الجزء ما لم يتحقّق فساد السابق ساقط، وإن كان الأمر بالمفهوم المقيّد سقوطه مراعى بعدم لحوق الثاني فلا يمكن قصد الامتثال بالثاني.
نعم لو كان رفع اليد عمّا وقع صحيحاً موجباً لالغائه صحّ قصد الامتثال بالثاني مع رفع اليد عن الأوّل، فانقدح أنّه لا يتحقّق الزيادة على تقدير كون عدمها شرطاً في المركّب إذا قلنا انّه يعتبر في صدق الزيادة سنخية الزائد مع بعض أجزاء المركّب، وظهر أنّه لا شك في فساد المركّب على تقدير الاكتفاء بالمكرّر مع عدم التدارك حيث يمكن التدارك لفقد الجزء ونقص المركب.
وكذا لا شك في أنّه لو كان المأخوذ في المركّب ذات الجزء ملحوظاً فيه الاطلاق من حيث الوحدة والتعدّد لا يكون التكرار مخلاًّ، للعلم بعدم منافاة المأتي به للمركّب وهذا الفرض يتصوّر فيما إذا كان المتعدّد فرداً واحداً للجنس المعتبر في المركّب؛ إمّا حقيقة كما في المسح بالنسبة إلى عرض الممسوح، فانّ مسح اصبعين مسح واحد كما أنّ مسح واحدها أيضاً مسح واحد، أو عرفاً كما في المسح بالنسبة إلى طول الممسوح، فانّ مسح الرجل إلى الكعبين وإن كان منحلاًّ عند العقل بمسحات الاّ أنّه عند العرف مسح واحد، وفيما إذا كان المتعدّد ملحوظاً شيئاً واحداً، كما إذا فرض أنّ المعتبر في الصلاة جنس الركوع الذي له فردان: أحدهما البسيط وهو الانحناء الواحد، وثانيهما المركّب من انحنائين ويكون تعيين كل منهما في الايجاد الخارجي بقصده أوّل الأمر بحيث لا يصح العدول عنه بعد الاشتغال بالجزء وفيما إذا كان الزائد جزءً مستحبّاً بحيث لو ترك لم يكن تركه مخلاًّ ولو فعل كان جزءً لما أتى في ضمنه، ولا يتخيّل انّ هذا حينئذٍ يكون جزءً للمركّب، لأنّ ما اعتبر في المركّب لا يمكن وجوده بدونه، وانّما يكون ذلك جزءً للفرد الموجود في الخارج، ويكون للمركّب فردان أحدهما المشتمل على ذلك، والآخر ما لم يشتمل عليه، وهكذا الأمر
في الصورة الثانية أيضاً كما لا يخفى.
ولمّا كان حكم الأصل بالنسبة إلى أقسام الزيادة مختلفاً لا بأس بالاشارة إلى أقسامها فنقول: زيادة الجزء يتصوّر على وجوه:
الأول: أن يأتي بالجزء بقصد كونه جزءً مستقلاً إمّا شرعاً لاعتقاده ذلك أو تشريعاً.
الثاني: أن يقصد كون الزائد والمزيد عليه جزءً واحداً كأن يعتقد أنّ الركوع الواجب في الصلاة هو الصادق على الواحد والاثنين.
الثالث: أن يأتي بالزائد بدلاً عن السابق لرفع اليد عنه إمّا إقتراحاً في الاثناء للاستعجال، أو بعد الاتمام لتحصيل الثواب المترتّب على خصوص ما يأتي به ثانياً، وإمّا لأجل فساد الجزء السابق، والأصل في الصورة الاولى بقسميها الفساد، لأنّ ما قصد به الامتثال غير المأمور به، وما يقع به الأمتثال غير مقصود، والأصل في البواقي الصحّة، لأنّ مرجع الشك إلى مانعية الزيادة، والأصل البراءة عن وجوب ترك الزيادة عقلاً ونقلاً كما مرّ في الشك في الجزئية والشرطية ويستفاد من الشيخ الأجلّ في رسالة(١) البراءة ونقل عنه المناقشة في أثناء البحث في الفرق بين الصور، وحاصلها: أنّ كون ما أتى به غير المأمور به مبني على أن يكون عدم الزيادة معتبراً في المأمور به وهو غير معلوم.
وبالجملة: المأمور به إمّا الجنس الموجود في ضمنه ما فيه الزيادة وفيما ليس فيه الزيادة أو خصوص ما ليس فيه الزيادة، فان كان الأوّل فقد تحقّق في الخارج مقروناً بقصد الامتثال، وإن كان الثاني فلا دليل على كونه هو المأمور به، ومقتضى البراءة سقوطه عن المكلّف في مرحلة الظاهر فعدم تعلق قصد الامتثال به لا يضرّ بسقوط العقاب عن المكلف باتيانه المشتمل على الزيادة.
والقول: بأنّ المأمور به وإن كان هو الجنس لم يتعلّق به قصد الامتثال
____________________
(١) فرائد الاصول: ص ٤٨٨.
وخصوص المشتمل على الزيادة الذي تعلق به قصد الامتثال من حيث خصوصيته لا يكون مأموراً به.
يدفعه: أنّ معتقد كون المأمور به هو الزائد يأتي بالمشتمل عليه، لأنّه مأمور به فهو قاصد في اتيانه بذلك موافقة الأمر، ووجود الجنس في الخارج الذي هو مطلوب من المكلّف عين وجود الفرد في الخارج، فايجاد الجنس في الخارج مقرون بقصد الامتثال، وقصد الامتثال بهذا الوجود الخارجي الذي هو عين وجود الجنس والنوع لأجل خصوصية خارجية ليس إلاّ تصرّفاً في أمر عقلي لا يضر بحصول الامتثال بذلك الوجود.
والحاصل: أنّ الحيثية مكثّرة للموضوع في ظرف الذهن، وأمّا في الخارج فلا فالحيثيتان الموجودتان في الفرد في الخارج لا توجبان تعدّد الفرد في الخارج، نظير صلاة من يعتقد أنّ الأجزاء المستحبّة واجبة، وصوم من يعتقد أنّ بعض ما لا يجب تركه يكون تركه واجباً، فانّه حينئذٍ لا يكون قاصداً للامتثال مع هذه الحالة الاّ بالخاص من حيث الخصوصية.
ولا يمكن أن يقال: إنّ الصلاة المشتملة على الأجزاء المستحبة عين المأمور به في ظرف الذهن، ضرورة أنّ الأجزاء المستحبة أجزاء لذلك الفرد، وينتفي بانتفائها ولا يكون أجزاء للمركب، لأنه لا ينتفي بانتفائها ولا يعقل جزئية شيء لشيء وعدم انتفائه بانتفائه.
وبالجملة: لا فرق بين صلاة من يعتقد كون الصلاة ذات ركوعين مستقلين، وبين صلاة من يعتقد كون الصلاة ذات ركوع غير مشروط بالانفراد والتعدّد مع ايجاد المتعدّد في الخارج إلاّ من حيث كون الاتيان بالصلاة في الصورة الثانية من حيث الاندراج تحت عنوان ذات الركوع، وفي الصورة الاولى من حيث الخصوصية والحيثية لا يوجب تكثر الموضوع.
ولكن ذلك كلّه في صورة كون الآتي بالمشتمل على الزيادة إتيانها لا بقصد التشريع، وأمّا في صورة التشريع فالظاهر الفساد، لأنّه لم يقصد الامتثال حينئذٍ
بالمرّة، والظاهر أنّه لا فرق بين أن يكون قاصداً للزائد جزءً مستقلاً، وبين أن يكون قاصداً وحدته مع المزيد عليه، والظاهر أنّ القائل بالصحّة في الصورة الثانية لا يريد بها الأعم من صورة التشريع، ويشهد لذلك تمثيله بصورة الاعتقاد مع عدم التعرّض لصورة التشريع.
ثم اعلم: أنّ الزيادة في الصورة الثالثة في صورة فساد الجزء السابق يتحّقق في الجزء السابق لأنّ المأتي به ثانياً مطابق للأمر المتعلّق بالجزء دون المأتي به أوّلاً، وأمّا في صورة الصحة فان قلنا بأنّ رفع اليد موجب لالغاء المأتي به أو لا يكون هو الزائد، والاّ فالزائد هو الثاني فتأمّل.
فانقدح أنّ الاصل في كون الزيادة مبطلة هو البراءة في جميع الصور، وليس هنا ما يمنع عن مقتضاه، وظهر أنّ هذا كلّه حكم كلّ ما شك في مانعيته.
ثم اعلم أنّه ربما يتمسّك لاثبات صحّة العبادة عند الشك في المانعية باستصحاب الصحّة.
وقد أورد: بأنّ المراد من الصحّة ليس صحة تمام العبادة، لأنها لم توجد بعد، وصحة الأجزاء السابقة على حدوث مشكوك المانعية لا شك فيها، لأنّها إمّا عبارة عن مطابقتها للأمر المتعلق بها، أو ترتب آثارها عليها، ولا ريب في حصول الأول، لأنّ ما وقع لا ينقلب عمّا وقع عليه وكذا الثاني، لأنّ آثار الاجزاء السابقة ليس إلاّ حصول الماهية منها ومن سائر ما يعتبر في الماهية إن لحقت بها والشك في مانعية الموجود راجع إلى الشك في أنّه هل ينضمّ بفعل سائر الأجزاء جميع ما يعتبر في الماهيّة بالأجزاء السابقة لعدم اعتبار عدم ما يشك في مانعيته في الماهية، أو لا ينضمّ لاعتباره فيها وليس من آثار صحّة الأجزاء السابقة حصول الانضمام بفعل سائر الاجزاء.
والحاصل: أنّ صحّة الأجزاء السابقة ليس مشكوكاً فيها، وعلى تقدير تحقّق الشك فيها، ليس من آثارها حصول الكل بضمّ باقي الأجزاء عند حصول مشكوك المانعية، بل اليقين بالصحّة يجمع مع الشك في ذلك.
وقد يدفع هذا الاشكال في بعض الموارد، وهو ما إذا كان الشك في قاطعية الموجود لا مانعية ذلك - بناءً على أنّ المانع هو ما يكون عدمه معتبراً في المأمور به - نظير سائر ما يعتبر فيه من الأجزاء والشرائط من غير أن يكون حدوثه موجباً لحدوث وصف في الأجزاء، أو زوال وصف فيها، فهو في الحقيقة راجع في تركّب الماهية من امور وجودية وامور عدمية، والقاطع ما لا يكون عدمه معتبراً في المأمور به بل يكون وجوده موجباً لزوال ما اعتبر في الماهية من الهيئة الاتّصالية القائمة بمجموع الأجزاء، فالشك عند حدوث ما يشك في قاطعيته، راجع إلى الشك في بقاء تلك الهيئة الاتّصالية وعدم بقائها، فيستصحب بقاء قابلية الأجزاء السابقة للحوق سائر الأجزاء بها، إذ مع عدم وجود القاطع لها هذه القابلية، ويحدث عند الشك في حدوث القاطع شك في بقاء تلك القابلية وهذا البيان لا يجري في الشك مع وجود المانع أمّا عدم جريان استصحاب الهيئة فواضح، إذ ليس الشك في ذلك، وأمّا الشك في بقاء القابلية فلإبقاء تلك القابلية أثرها عدم وجوب إستئناف الأجزاء السابقة لا تحقّق ما يعتبر في الماهية وهو عدم المانع فالأصل بالنسبة إليه مثبت.ويمكن المناقشة في الاستصحابين في الصورة الاولى: أمّا في استصحاب الهيئة فبأن يقال: إن كان المراد من الهيئة القائمة بمجموع الأجزاء فهي لم تتحقّق بعد، فإن كان المراد: القائمة بالأجزاء السابقة فهي مقطوع البقاء، ولا تنفع في إثبات حصول الهيئة المعتبرة في العبادة باتيان سائر الأجزاء، وأمّا في استصحاب القابلية فلأنّها لا تثبت حصول الهيئة بلحوق سائر الأجزاء.
ويدفع الاولى: بأنّ إستصحاب الهيئة من الاستصحابات العرفية الغير المبنية على التدقيق العقلي، فكما أنّ الماء المسبوق بالكرية يستصحب كريتها - بناءً على أنّ الماء حال الشك هو الماء السابق - كذلك يستصحب الهيئة - بناءً على كون الهيئة امراً واحداً قائماً بالاجزاء السابقة وبالمجموع - وعن الثانية بأنّ الغرض من استصحاب القابلية ليس إلاّ عدم وجوب إستئناف الأجزاء السابقة، إذ على تقدير عدم بقائها يجب الاستئناف.
ويرد عليه: أنّ عدم وجوب الاستئناف ليس من آثاره حصول الهيئة الاتصالية الواجب إحرازها بضمّ سائر الأجزاء بما سبق.
هذا والتحقيق أنّ الكلام في مقامين: الأوّل: في حكم القاطع، الثاني: في حكم المانع.
أمّا الأوّل: فنقول:
إنّ معنى كون الشيء قاطعاً وناقضاً إقتضاء وجوده رفع أمر لولا حدوثه لكان ذلك الأمر باقياً، فاذا حكم الشارع على فعل بأنّ ذلك ناقض للعبادة يكون معناه: أنّ هذا الفعل موجب لرفع أمر كان حاصلاً قبل حصوله وكان ذلك باقياً لولا حدوث ذلك، وتحقّق هذا المعنى حقيقة في العبادة من غير ابتناء على المسامحة العرفية انّما هو باشتمال كل جزء على اثر بقاء ذلك الأثر في حال فعل ما يلحقه من الأجزاء معتبراً في حصول أثر اللاحق وترتّبه عليه، ويكون حدوث الجزء موجباً لحدوثه وبقائه، ويكون حدوث ما سمّاه الشارع ناقضاً موجباً لرفع ذلك الأثر - نظير الحدث بالنسبة إلى الطهارة الحاصلة من الوضوء -.
فمعنى كون الضحك ناقضاً للصلاة: أنّ لكلّ جزء من أجزاء الصلاة الذي يلحقه الضحك أثراً، يكون بقاء ذلك الأثر معتبراً في أثر ما يلحقه الأجزاء ويكون الضحك رافعاً لذلك الاثر، مثلاً التكبير أثره مرتبة من القرب يكون بقاء تلك الجزئية في ترتّب ما يترتّب على القراءة معتبراً ويكون الضحك المتخلّل بين التكبير والقراءة موجباً لارتفاع ذلك القرب.
ولا يتوهم انّ لازم ما ذكرنا كون كل جزء لاشتماله على أثر مخصوص به واجباً نفسياً، لجواز أن يكون المطلوب حصول مرتبة من القرب وهي تحصل بفعل الاجزاء شيئاً فشيئاً، ويكون بقاء ما يحصل من كلّ جزء منوطاً بعدم لحوق الضحك، فاذا شككنا في قاطعية شيء موجود، نشك في أنّه هل ارتفع بحدوث ذلك ما كان حاصلاً بفعل الجزء أم لا، والأصل عدم حدوث ما يرفع ذلك وكذلك الأصل بقاء صحّة الجزء السابق - أي بقاء أثره الحاصل بفعله - ويرتّب على هذا الاستصحاب
صحة الجزء اللاحق وعدم وجوب استئناف الجزء السابق.
لا يقال: إنّ هذا الاستصحاب لا يثبت به عدم رافعية الأثر الموجود المشكوك رافعيته.
لأنّا نقول: هب أنّه لا يثبت به ذلك ولا يترتّب على ذلك فساد، لأنّ الغرض من إحراز ذلك ليس إلاّ صحّة اللاحق وعدم وجوب استئناف السابق، وهذا الغرض يترتّب على استصحاب عدم وجود كلي الرافع وإن لم يعلم منه حكم الفعل الموجود.
ثم إنّ ما ذكرنا بعينه جار في صورة الشك في حصول ما يعلم قاطعيته، بل فيه أظهر.
أمّا الثاني، فالكلام فيه مبنيّ على مقدّمة هي:
أنّ الأمر المتعلق بالجزء تبعاً اللازم من مطلوبية المركّب هل هو متعلّق بالجزء المقيّد بعدم لحوق ما يمنع عن حصول المركّب منه ومن سائر الاجزاء، أو متعلق بالجزء من غير تقييد، وعلى الثاني فهل يكون سقوط ذلك الأمر مراعى بعدم لحوق ما يمنع عن ذلك، أو يكون سقوطه غير منوط بشيء، غاية الأمر أنّه إذا حصل المانع عن انضمام سائر الأجزاء يعود الأمر بالجزء لأجل حصول الداعي للأمر، والظاهر هو الاحتمال الأخير لبطلان الأوّلين وعدم وجود احتمال آخر، أمّا الثاني فظاهر، وأمّا الأول فامّا بطلان الاحتمال الأوّل: فلأن منشأ الأمر بالمقدّمة ليس الاّ التوقّف، وهو لا يكون إلاّ متعلّقاً بذات الجزء المعراة عن تقييد.
لا يقال: الجزء الملحوق بالمانع لا يتوقّف عليه الكل وما لم يلحقه يتوقّف عليه، لأنّه لا يلزم من عدم الأوّل عدم المركّب ويلزم من عدم الثاني عدمه.
لأنّا نقول: الذي تتقوّم به الماهية المركّبة هو ذات الأجزاء، وأمّا عدم المانع فهو بنفسه معتبر في الماهية وتتقوّم به وكذلك عدم القاطع، غاية الأمر أنّ الأوّل يتقوّم به الماهية بنفسه والثاني تتقوّم بملزومه الذي هو الهيئة الاتّصالية أو أمر آخر، فليس ما تعلّق به الأمر المقدّمي أمراً مقيّداً، ولو كان ما ذكرته من الاعتبار موجباً للتعدّد
والانقسام، واختصاص للأمر الغيري نفسه دون آخر، يجري ذلك في كل جزء بالنسبة إلى ما يلحقه من الأجزاء ولا تلتزم به.
وأمّا بطلان الاحتمال الثاني: فلأن الغرض من الأمر المقدّمي بأيّ مقدّمة تعلّق ليس إلاّ رفع امتناع تحقّق ذي المقدمة من جهة عدم تلك المقدمة، ولا ريب أنّ ذلك الغرض يحصل بمجرّد حصولها الجزء في الخارج، واستمراره ليس أمراً مرتّباً عليه حتى يكون غرضاً من حصوله، بل منوط بعدم ما يمنع منه حصول الماهية من الجزء الموجود وسائر الاجزاء الاخر، فارادة استمراره موجب للأمر بابقاء عدم ذلك المانع، غاية الأمر أنّه اذا حصل ذلك المانع يتجدّد معه أمر مقدّمي بذلك الجزء لحصول الداعي للأمر.
نعم لو كان الغرض من الأمر بالمقدّمة رفع الامتناع من جهة عدم تلك المقدّمة واستمرار عدم الامتناع، كان الامتثال مراعى بعدم المانع، لأنّه إتيان المأمور به على وجه يطابق غرض المولى والمطابقة لا يحصل الاّ بعدم المانع.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ ما يعتبر عدمه تارة يعتبر عدمه في المركّب لأجل أنّه يكون بنفسه من مقوّماته وأجزائه، واخرى يعتبر لأجل إخلاله بالسابق وسقوطه عن قابلية لحوق الباقي به مع وجود ذلك، وثالثة لأجل اعتبار عدمه في لحوق المتأخّر بالسابق بمعنى أنّه يسقط الباقي عن قابلية اللحوق بالسابق، وذلك كالسكوت الطويل بالنسبة إلى الأجزاء التي يعتبر فيها الموالاة.
أمّا الكلام في الصورة الاولى: فتارة في الشبهة الحكمية، واخرى في الموضوعية.
أمّا الاولى: فالظاهر أنّه يجب البناء على ما فعل من الأجزاء وإتمامه والإجتزاء به في الظاهر إلى أن ينكشف الخلاف، ولنذكر أوّلاً ما يقتضيه المانعية ثم ما يدفع به تلك المقتضيات عند الشك فيها بسبب الشك في حدوث ما يقتضيها.
فاعلم أنّ ما علم مانعيته إذا وجد في الخارج يقتضي أمرين:
الأوّل: وجوب استئناف ما فعله لأجل عروض ما يمتنع معه كون ذلك جزءً فعلياً للعبادة.
الثاني: عدم حصول التركّب المعتبر في مفهوم العبادة.
وبسبب هذين الأمرين يمتنع إتيان باقي الأجزاء أيضاً وامتثال الأوامر المتعلّقة بها، إذا كان بين الأجزاء ترتيب، فانّ الواجب الغيري حينئذٍ ليست ذلك الجزء، بل هو ذلك مقيّداً بسبق ما يعتبر سبقه عليه، والمفروض أنّه لم يحصل، مثلاً لو فرضنا أنّ زيادة التكبير مانعة وفعلها يحدث بسبب ذلك أمراً باعادة التكبير بقصد الدخول في الصلاة ويجب عليه تركها بعده ولا يقدر ما لم يستأنف التكبير ولم يترك الزيادة على امتثال الأمر الغيري المتعلّق بالقراءة وغيرها من الأجزاء، لأنّ المأمور به بالأمر الغيري ليس مطلق القراءة بل هو القراءة بعد التكبير وترك الزيادة.
إذا عرفت ذلك فنقول: إذا شك في مانعية شيء صدر منه يكون شكّه في ذلك موجباً للشك في وجوب استئناف ما سبق، وللشك في إتيان جميع ما يعتبر في المركّب لو أتى بباقي الأجزاء، وللشك في اتيان باقي الأجزاء على وجه يطابق الأوامر المتعلقة، فإذا دلّ الدليل الشرعي - مثل استصحاب عدم فعل ما يعتبر تركه في المأمور به - على أنّ ترك ما يكون مانعاً حاصل بحكم الشارع، يكون مقتضى ذلك وجوب البناء على عدم حدوث أمر ممّا سبق فعله، وسقوط العقاب على ترك المركّب المستند إلى ترك ذلك الجزء المأتي به، وفعل ما يجب تركه إذا أتى بباقي الأجزاء، والإكتفاء باتيانه في هذه الحالة باقي الاجزاء التي يعتبر في سقوط الأمر المتعلّق بها، وعدم العقاب على ترك المركّب المستند إلى تركها ايجادها في حال سبق فعل الجزء السابق وترك المانع، فاذا حصل للمكلّف الأمن من العقاب من جميع هذه الوجوه بواسطة ذلك الدليل يكون آمناً من العقاب على مخالفة الأمر النفسي المتعلّق بالمركّب فلا موجب للاستئناف وترك مشكوك المانعية وعدم دلالة الأصل المذكور على حصول الامتثال للأمر النفسي، وعدم مانعيّة الموجود بعد الأمن من العقاب على المخالفة لو كان ما أتى به غير مطابق للأمر النفسي لا يضرّ بحال المكلف، لأنّ وجوب إحرازه - حيث يحكم به العقل - انّما هو لأجل توقّف الفرار عن العقاب على الاحراز وهو غير متوقّف على ذلك كما عرفت.
والحاصل: أنّ الذي يجب على المكلّف إتيان الجزء السابق على وجه يصلح لأن يلحق به باقي الأجزاء وترك المانع الذي اعتبر في المأمور به واتيان الاجزاء الباقية على وجه يطابق الأوامر المتعلقة بها فاحراز ترك المانع واجب لكونه موجباً لليقين ببقاء قابلية ما سبق عليه، ولكونه في نفسه مطلوباً غيريّاً ولكون تحققه من شرائط صحة الاجزاء اللاحقة حقيقة واصالة الترك دليل لثبوت شرائط الأجزاء اللاحقة شرعاً ولثبوت جزء العبادة وهو الترك ودليل لبقاء القابلية في الاجزاء السابقة كما ان استصحاب الطهارة موجب لثبوت شرط الصلاة وهي الطهارة فالمكلف إذا أتى بباقي الاجزاء يكون شرعاً، آتياً جميع ما يعتبر في المأمور به.
وأمّا الثانية: - أي الشبهة الموضوعية - فالحكم يختلف باختلاف كيفية عدم المانع في المركّب، فانّه قد يكون عدمه من حالات المصلّي مثل لبس المصلّي جلد ما لا يؤكل لحمه في حال الصلاة، وقد يكون من حالات بعض ما على المصلّي مثل طهارة اللباس وعدم كونه جلد ما لا يؤكل لحمه، وقد يكون من إعتبارات نفس الفعل بحيث يكون المطلوب الفعل الواقع في غير ما لا يؤكل لحمه، وقد يكون نفس الترك من الأجزاء مثل عدم التكتّف، وعدم قول آمين في أثناء الصلاة، فإن كان من اعتبارات المصلّي: يكون جريان الأصل وعدمه تابعاً لليقين السابق المتعلق بحال المصلّي فيقال عند الشك في لبس ما يكون لبسه مانعاً: انّ المصلّي لم يكن لابساً في الزمان السابق والأصل عدمه، ونظيره استصحاب طهارة المصلّي من الحدث، وإن كان من اعتبارات ما عليه ينبع حال ذلك، فإذا شكّ في طهارة الثوب أو وقوع ما يمنع كونه عليه أنّ الأصل طهارته، والأصل عدم وقوع ذلك عليه إذا كان مسبوقاً بالطهارة وعدم الوقوع.
ومن هنا علم أنّه إذا شك في أصل اللباس من حيث كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه لم يجر الأصل لعدم وجود الحالة السابقة، وكذلك الأمر عند الشك في كونه حريراً إذا قلنا: إنّ مانعية الحرير من اعتبارات اللباس، وإن كان من اعتبارات الفعل لم يجر فيه الأصل، لأنّه ليس هناك حالة سابقة للفعل الخاص من
حيث وقوعه في غير ما لا يؤكل لحمه، وإن كان نفس الترك من الامور المعتبرة في العبادة - نظير ترك التأمين والتكتّف - فبالأصل يحرز عدمه.
ثم اعلم أنّه إذا كان الشك في المانعية راجعاً إلى الشك في كون اعتبار عدم الشيء من خصوصيات وقوع الفعل، كما إذا شككنا في أنّ المأمور به هل هو الصلاة الواقعة في غير ما لا يؤكل لحمه أو مطلق الصلاة في أيّ شيء وقع فلا يخفى أنّ أصالة عدم المانع لا يجري هنا أيضاً وإنّما المجدي في المقام هو أصالة البراءة عن القيد الزائد بناءً على إعتبارها في الأجزاء العقلية التي لا يكون الشك في جزئيتها راجعاً إلى الشك في كون المأمور به الأقل في الخارج أو الأكثر في الخارج وقد مرّ الكلام فيه.
فان قلت: أيّ فرق بين ما يكون عدمه مستقلاً من الأجزاء، وما يكون عدمه من إعتبارات وقوع الفعل، فانّه كما يكون المطلوب في الثاني الفعل الخاص وهو الواقع مثلاً في غير ما لا يؤكل لحمه، كذلك يكون المطلوب في الأوّل الأجزاء المقرونة بعدم ذلك، فكما أنّ الأصل لا يفيد في الثاني كذلك لا يفيد في الأوّل.
قلت: بينهما فرق واضح، فانّ العدم إذا كان في نفسه مطلوباً لا يكون المطلوب إلاّ أفعالاً وتروكاً والأوّل يحرز بالوجدان والثانية بالأصل وليس المطلوب حينئذٍ الأجزاء المقرونة بالترك، بل المطلوب مجموع امور أحدها الترك، أمّا إذا كان من إعتبارات نفس الفعل كان المطلوب أمراً وجودياً خاصاً وهو الفعل المقرون بكذا، واستصحاب الترك لا يثبت به اقتران الفعل بالترك الذي هو من خصوصيات المأمور به، وانما لم نتكلّم في ذلك في الشبهة الحكمية، لأنّ الشك من هذه الحيثية راجع إلى الشك في كون المأمور به الأمر المقيّد فيكون راجعاً إلى الشك في الشرطية وقد مرّ تفصيله.
وأمّا الكلام في الصورة الثانية: فالظاهر أنّه كالاولى إلاّ أنّ بينهما فرقاً من حيث إنّه لا يحتاج هنا إلى أصلين: أحدهما أصالة عدم حدوث أمر جديد بالأجزاء السابقة، والآخر أصالة عدم وجود ذلك المانع، بل الأوّل مغن عن الثاني، لأنّه
لا يكون الشك في وجود المانع حينئذٍ الاّ سبباً للشك في حدوث الأمر الجديد، إذ المفروض أن ترك ذلك المانع ليس مطلوبيته الاّ لأجل اقتضاء وجوده فساد الأجزاء السابقة، وليس هو في نفسه من مقوّمات المأمور به، والظاهر أن القواطع كلّها من هذا القبيل، فإذا أثبتنا عدم وجود الأمر الجديد بالاصل، يحصل بالاتيان بسائر الاجزاء براءة الذمة عن المأتي به.
فإن قلت: إنّ الواجب في مقام الامتثال إحراز حصول المأمور به في الخارج، والأصل المذكور وهو بضميمة الأصل الآخر في الصورة الاولى لا يثبت به عنوان المأمور به.
قلت: قد مرّ جوابه فانّ الحاكم بوجوب الامتثال ليس إلاّ العقل، وهو لا يحكم إلاّ بوجوب فعل يسقط به العقاب، وأمّا الصورة الثانية فالظاهر أنّه لا مجرى للأصل فيه، لأنّ أصالة عدم وجود المانع لا يثبت كون ما يأتي به من الأجزاء مرتبطة بالأجزاء السابقة.
ثمّ انّه قد يستدلّ لصحّة العبادة عند الشك في المانعية: بقوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم)(١) فانّ حرمة الابطال هو ايجاب المضيّ وهو ملازم للصحّة، للاجماع على أنّ ما يجب المضي فيه يكون صحيحاً إلاّ الصوم والحج.
وتحقيق الكلام في الآية: أنّ الابطال هو التأثير في عروض وصف البطلان على العمل بعد أن لم يكن كذلك، كما في الاكرام، والاقامة، والاغناء، فانّ معناها: جعل الشخص مكرماً وقائماً، وغنياً بعد أن لم يكن كذلك، ولا ريب أنّ هذا المعنى يقتضي سبق اتّصاف العمل بعدم البطلان وهو ملازم للصحّة، ومعنى الآية ان حمل الابطال فيها على هذا المعنى جعل العمل لغواً بعد أن كان ذا أثر فهو راجع إلى النهي عن الأعمال الموجبة لحبط العمل.
ويؤيّده: نفيه بقوله تعالى: (لا تبطلوا صدقاتكم بالمن)(٢) بقرينة قوله تعالى:
____________________
(١) محمّد: ٣٣.
(٢) البقرة: ٢٦٤.
(ثم لا يتّبعون ما أنفقوا منّاً ولا أذى)(١) .
ويحتمل أن يكون المراد من الابطال: ايجاد العمل باطلاً نظير قولهم ضيّق فم الركيّة أي أوجده ضيّقاً، فمعنى الآية طلب ترك إتيان العمل باطلاً، ولا يرتبط بالمقام سواء كان النهي إرشادياً أم لا كما لو حمل على المعنى الأول.
ويحتمل أن يكون المراد قطع العمل، ويمكن إرجاعه إلى الوجه الأوّل - بناءً على أنّ المراد من العمل الأعم من الواجبات الغيرية والنفسية - ولا ريب أنّ الاحتمال الأوّل هو المتعيّن لما عرفت من أنّه المعنى الحقيقي للابطال، وقد استعمل فيه في الآية الاخرى، ولأنّه المناسب للآيات المتقدّمة على هذه الآية وهي قوله تعالى: (يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول)(٢) لأن إتيان العمل باطلاً مخالفة للّه والرسول فالأمر بالاطاعة يغني عن النهي عن ذلك، مضافاً إلى ما ورد من تفسير الآية ما يطابق المعنى الأوّل.
فحصل أنّ الاستدلال بها - مع قطع النظر عمّا يأتي الاشارة إليه - إنّما يمكن إذا اريد به المعنى الثالث، وقد عرفت أنّ الظاهر منها هو المعنى الأوّل.
الاّ أن يقال: إنّ المعنى الثالث راجع إلى المعنى الأوّل، لكنه يبعد دعوى ظهور الآية فيما يكون فيه جهة مطلوبية ذاتية إلاّ أنّ كون قطع العمل بعد فعل ما يشك في مانعيته ابطالاً محلّ شك، لأنّ المشكوك لو كان مانعاً لا يكون القطع بعد فعله ابطالاً وهو ظاهر.
ومن هنا ظهر حال استصحاب حرمة القطع، واستصحاب وجوب الاتمام، لأنّه يكون الشك في المانعية موجباً للشك في كون النقض إبطالاً وفي القدرة على الابطال ومعه يكون موضوع المستصحب وهو الوجوب مشكوك البقاء وكون إلحاق الباقي اتماماً، لأنّ كون المأتي به اتماماً مبني على عدم كون ما يشك في مانعيته
____________________
(١) البقرة: ٢٦٢.
(٢) النساء: ٥٩.
معتبراً في المأمور بوجه من الوجوه.
الاّ أن يقال: إنّا نستصحب القدرة على الاتمام وكون اتيان باقي الاجزاء قبل حدوث ذلك إتماماً.
ويرد على الأوّل أنّ استصحاب القدرة انّما يثبت به شرط وجوب واقعاً وهو القدرة وثبت به موضع الوجوب الواقعي ولكن ترتيب آثار بقاء القدرة الذي هو راجع إلى ايجاب الاتمام ظاهراً موقوف على القدرة على الاتمام وهو لا يثبت بهذا الاستصحاب، لأنّ الاستصحاب لا يثبت به شرائط نفسه، وأمّا إستصحاب كون الأجزاء اللاحقة اتماماً فان كان جارياً، يغني عن استصحاب القدرة.
ولكنّه يرد عليه أنّ كون فعل هذه الأجزاء الباقية إتماماً من غير اعتبار مسبوقيتها بالترك في حصول الاتمام بها مشكوك حتى في حال سبقها بترك مشكوك المانعية فلعلّ موضوع الاتمام هو الجزء المسبوق بترك المشكوك مانعيته.
والحاصل: إن كون الجزء المسبوق بترك مشكوك مانعيته اتمام يقيني: لأنّه إمّا أن يكون اتماماً مع المقيّد أو مطلقاً وعلى أيّ الأمرين يكون ما به الاتمام موجوداً في ذلك العنوان، لكنّه لا يكون فعل هذه الأجزاء مصداقاً لذلك العنوان، وأمّا كون الجزء إتماماً من غير اعتبار سبق ترك مشكوك المانعية في الاتّصاف بذلك حتى في حال السبق فاتّصاف الأجزاء المطلقة القدر المشترك بين المسبوق بالترك وغير المسبوق به بالاتمام مشكوك، فكيف يستصحب الاتمام فتأمّل.
وممّا ذكرنا علم أنّ الأمر لو دار بين رفع اليد عمّا يكون مشغولاً به والاستئناف وبين الاتمام والاعادة، كان الأوّل هو المتعيّن، لأنّه مع القدرة على مراعاة الجزم المعتبر في تحقّق الامتثال حيث يقدر عليه يأتي بالمأمور به على وجه لا يحصل معه مراعاة الجزم واشتمال فعله على هذا الوجه على مراعاة الاحتياط من جهة احتمال كون القطع ابطالاً محرّماً لا يسوغ ترك الاحتياط من تلك الجهة، مع كونه إمّا واجباً، أو أهم من ذلك.
اللهمّ إلاّ أن يقال: إنّ فعل المبطل عقيب ما يشك في مانعيته وقبل إتيان باقي
الأجزاء يكون حراماً فيكون الاتمام في الظاهر واجباً والاعادة واجبة، لعدم القطع بحصول المأمور به لا واقعاً ولا ظاهراً، وحينئذٍ يكون طريق إمتثال الأمر منحصراً في الاتمام والاعادة، أمّا حرمة فعل المنافي فهي إمّا لإستصحاب الحرمة، لأنّه كان قبل وجود مشكوك المانعية حراماً، أو لأجل أنّها من أحكام الكون في العبادة وهو مستصحب، لأنّ المكلّف كان في العبادة قبل فعل مشكوك المانعية، وبعد فعله يشك في أنّه خرج بسببه عن العبادة أو هو باق فيها فيستصحب الكون في العبادة.
ويرد على الوجه الأوّل: أنّ الذي كان موصوفاً بالحرمة ليس هو فعل ذات المنافي، بل هو إخراج الجزء القابل للحوق الباقي عن قابلية لحوق الباقي به وكون فعل المنافي إخراجاً للقابل عن القابلية مشكوك، لاحتمال خروجه عن القابلية قبل فعل ذلك.
اللهمّ إلاّ أن يستصحب القابلية وحينئذٍ فلا حاجة إلى إستصحاب الحرمة، ولا يجب الاعادة ايضاً إذا لم يكن المانع المشكوك على تقدير مانعيته مخرجاً للأجزاء اللاحقة عن قابلية اللحوق بما سبق وقد مرّ بيانه.
واعلم أنّ ما ذكرنا كلّه انّما كان في الزيادة عمداً، وأمّا الزيادة سهواً فيما يقدح زيادته عمداً فالكلام فيه هو الكلام في النقص سهواً، فانّه يرجع إلى الاخلال بالشرط سهواً، وقد مرّ أنّ الشيخرحمهالله بنى على أنّ مقتضى الأصل فيه هو البطلان(١) ، وقد مرّ ضعفه وأنّه يمكن القول فيه بالصحّة.
وقد ظهر من جميع ما ذكرناه في الزيادة والنقيصة: أنّ مقتضى الأصل في الزيادة - سهواً كان أو عمداً - عدم البطلان.
وأمّا من بنى فيه على أصالة البطلان فيلزمه القول بأصالة البطلان في الزيادة السهوية إن ثبت أنّ الزيادة العمدية مفسدة، وليس له الخروج عن هذه القاعدة الاّ بالنص بالبطلان.
____________________
(١) فرائد الاصول: ص ٤٩٤.
وقد عرفت أيضاً: أنّ الأصل في كل جزء شك في كونه ركناً عدم الركنية، سواء كان المراد من الركن ما يبطل بنقيصته سهواً العبادة، أو كان المراد ما يبطل بنقيصته سهواً وبزيادته عمداً أو سهواً.
نعم من بنى على أنّ النقيصة السهوية، الأصل فيها بالبطلان دون الزيادة يلزمه التفصيل في الشك في الركنية فيقول: إنّ الاصل هو الركنية إن كان المراد التفسير الأول، وعدمها إن كان هو الثاني.
والشيخ في الرسالة: حكى عدم الفصل في الصلاة بين الاخلال سهواً، وبين الزيادة عمداً وسهواً فقال - بناءً على مذهبه -: إنّ أصالة البراءة الحاكمة بعدم البأس بالزيادة، معارضة - بضميمة عدم القول بالفصل - بأصالة الاشتغال الحاكمة ببطلان العبادة بالنقص سهواً، وحينئذٍ فان جوّزنا الفصل في الحكم الظاهري الذي يقتضيه الاصول العملية فيما لا فصل فيه من حيث الحكم الواقعي فيعمل بكل واحد من الأصلين، وإلاّ فاللازم ترجيح قاعدة الاشتغال على البراءة كما لا يخفى(١) .
وأورد عليه: بأنّ التعارض ليس بين الأصلين، بل التعارض بين الاطلاق الآمر القاضي بعدم كفاية الناقص، وبين أصالة البراءة الحاكمة بعدم بطلان ما اشتمل عليه الزيادة - بضميمة عدم القول بالفصل - وذلك لأنّ عدم كفاية ما نقص بعض أجزائه سهواً من مقتضيات إطلاق الأمر المقتضي لكون الواجب في حالتي الذكر والنسيان أمراً واحداً وهو التام الاجزاء، فالمعارضة حقيقة يكون بينهما ومع تسليم أنّ المعارضة بين الأصلين، فلا وجه لتقديم قاعدة الاشتغال.
وربّما يجاب: بأنّ مقتضى الاطلاق هو كون الواجب في الحالتين واحداً، وأمّا عدم سقوط الأمر بما لا يكون مأموراً به فليس من مقتضيات الاطلاق، والمفروض أنّه مقتضى نظر صاحب الرسالة - حيث بنى على عدم معقولية اختلاف الواجب بالنسبة إلى الذاكر والناسي - هو كون الناقص مسقطاً عن الواجب لا مأموراً به
____________________
(١) فرائد الاصول: ص ٤٩٤.
واقعاً، ووجه تقديم الاشتغال: أنّه لا يوجب قاعدة قبح التكليف بلا بيان - بضميمة عدم القول بالفصل - الأمن من العقاب في المورد الذي - لولا عدم القول بالفصل - حكم فيه بالاحتياط.
واعلم أنّ الأخبار في باب الزيادة كثيرة لا بأس بالاشارة اليها وإلى ما يستفاد منها وطريق الجمع بينها.
فمنها: ما يدلّ بظاهره على أنّ مطلق الزيادة مبطلة، كقولهعليهالسلام : من زاد في الصلاة فعليه الاعادة(١) .
وقولهعليهالسلام فيمن أتمّ في السفر أنّه يعيده قالعليهالسلام : لأنّه زاد في فرض اللّه(٢) بناءً على أنّ الرواية أعم من السهو والعمد، وأنّ المراد من فرض اللّه هو الصلاة.
وما ورد في الطواف من أنّه كالصلاة في أنّ الزيادة مبطلة(٣) .
ومنها: ما يدلّ على أنّ الزيادة السهوية مبطلة، كقولهعليهالسلام : وإذا استيقن أنّه زاد في المكتوبة فليستقبل صلاته(٤) .
ومنها: ما يدلّ على أنّ الزيادة مطلقاً غير مبطلة، كقولهعليهالسلام : تسجد سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة يدخل عليك(٥) .
ومنها: ما يدلّ على أنّ زيادة غير الأركان لا تكون مبطلة، كقولهعليهالسلام : « لا تعاد الصلاة الاّ من خمسة »(٦) . بناءً على أنّ لا تعاد شاملة للزيادة إمّا بأن يكون المعنى: لا تعاد الصلاة من طرف شيء ممّا يعتبر في الصلاة زيادة ونقيصة الاّ من
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب الخلل ح ٢ ج ٥ ص ٣٣٢ وفيه « في صلاته ».
(٢) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب الخلل ح ٨ ج ٥ ص ٥٣٢.
(٣) وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب السعي ح ٢ ج ٩ ص ٥٢٧.
(٤) وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب الخلل ح ١ ج ٥ ص ٣٣٢.
(٥) وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب الخلل ح ٣ ج ٥ ص ٣٤٦.
(٦) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ١٤ ج ٤ ص ٦٨٣.
خمسة، وعدم تصوّر الزيادة في بعض الخمسة مع تصوّره في الركوع والسجود لا يضرّ بحمله على الأعم من الزيادة والنقيصة، أو يكون المعنى « لا تعاد الصلاة من جهة نقص شيء » ويكون الشيء أعم من التروك المعتبرة في الصلاة، والفرق بين الوجهين: أنّ الأوّل يقتضي بطلان زيادة الركوع والسجود دون الثاني كما لا يخفى.
وكقولهعليهالسلام في عدم ابطال زيادة غير الركن وابطال زيادته، « لأنّه زاد في فرض اللّه »(١) بناءً على أنّ المراد من فرض اللّه هو الركوع أو الركعة بقرينة ما ورد: من أنّ بعض أجزاء الصلاة فرض اللّه وبعضها سنّة(٢) .
وجه الدلالة على أنّ زيادة غير الركن غير مبطلة: أنّ تعليل الاعادة بزيادة الركن - مع كون زيادة غير الركن حاصلة قبلها - موجب لعدم كون السابق موجباً للبطلان، والاّ كان العلّة هو السابق ولم يكن اللاحق مع صلوحه للعلّية أيضاً علّة، لأنّ المترتّبين الصالح كلّ منهما للعلّية يكون إستناد المعلول بالسابق وإلاّ لزم خروج العلة التامّة عن كونها علّة تامّة، أو تحصيل الحاصل وكلاهما محال.
إذا عرفت ذلك فنقول: قولهعليهالسلام لا تعاد الخ، حاكم على سائر الأخبار الدالّة على أنّ مطلق الزيادة مبطلة مثل قولهعليهالسلام : « من زاد » وقولهعليهالسلام : « لانه زاد في فرض اللّه » ، إلاّ أن يقال: إنّ قوله : « من زاد » ليس في مقام بيان اشتراط عدم الزيادة ليكون لا تعاد لكون معناه لا تعاد ممّا يعتبر في الصلاة حاكماً عليه، بل المقصود رفع ما لعلّه يتوّهم من أنّ الزيادة على تقدير الابطال لا يوجب الاعادة، وحينئذٍ يكون معارضاً لقوله لا تعاد، إلاّ أنّ الظاهر خلاف ذلك خصوصاً مع كون الزيادة من قبيل الموانع التي يكون بيان مانعيتها غالباً بالأمر بالاعادة إذا حصلت.
مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ شمول « لا تعاد » للزيادة السهوية في غير الأركان
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب صلاة المسافر ح ٨ ج ٥ ص ٥٣٢.
(٢) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب القبلة ح ١ ج ٣ ص ٢١٤ نقلاً بالمعنى.
بعد خروج الأركان عنها بالاستثناء أظهر من شمول « من زاد » لها، أو يقال: إنّ « لا تعاد » أقلّ فرداً من قوله « من زاد » وإن كانت النسبة بينهما عموماً من وجه، من حيث عموم « من زاد » للعمد والسهو والأركان وغيرها، وعموم « لا تعاد » للزيادة والنقيصة، لأنّ لا تعاد شامل للزيادة والنقيصة السهويتين في غير الأركان وقولهعليهالسلام « من زاد » يشمل الزيادة العمدية في غير الأركان وكذلك السهوية في غير الأركان وهذان القسمان يقابلان ما يشمله قوله « لا تعاد » ويشمله ايضاً قوله « من زاد » على زيادة الأركان عمداً وسهواً فتخصيصه بـ « لا تعاد » أولى من العكس، لأنّ « لا تعاد » أقلّ فرداً، وكذلك تخصيص بقولهعليهالسلام « لا تعاد » قولهعليهالسلام : « لكلّ زيادة ونقيصة تدخل عليك » بغير الأركان باعتبار ذيل لا تعاد وهو قوله الاّ من خمسة لانه اخص من قوله لكل زيادة وهو بعد اختصاصه بغير الأركان تخصيص قولهعليهالسلام : « من استيقن أنّه زاد » بغير الأركان.
فان قلت: النسبة بين قولهعليهالسلام : « لكل زيادة ونقيصة » وقوله: « من استيقن » ليست إلاّ التباين، إذ ليس الأوّل عامّاً واحداً، بل قوله: « لكل زيادة » عام وقوله: « ونقيصة » عام آخر، وملاحظة النسبة أوّلاً بين ذيل « لا تعاد » مع قوله « لكل زيادة » وتخصيص الثاني بالأوّل وإن جعل الثاني أخص من قوله « من استيقن » إلاّ أنّ باب التعارض لا يقتضي بأن يخصّص « من استيقن » بقوله: « لكل زيادة »، لأنّه لا يكون لقوله « لكل زيادة » بعد التخصيص ظهور في الباقي ظهوراً منعقداً بعد التخصيص، بل شموله للباقي انّما يكون بالظهور الأوّل الذي قبل التخصيص، وتلك الدلالة لا تقتضي تقديم الثاني على الأوّل، ولهذا من قال في قول القائل: أكرم العلماء ولا تكرم النحويّين ولا تكرم فسّاق العلماء، يخصص أكرم العلماء بقوله لا تكرم الفسّاق فرجع النسبة بين قوله: اكرم العلماء ولا تكرم النحوييّن عموماً من وجه، ردّ قوله بأنّ أكرم العلماء لا يكون له ظهور في الباقي ناشئاً من غير ما نشأ منه الظهور الأوّل.
قلت: إن صحّ التمثيل، وصح ما ذكرت من أنّه لا ينعقد لقوله « من زاد » ظهور
في الباقي إلاّ أنّه بعد التخصيص يكون أظهر في شمول ما عدا الأركان من شمول « من استيقن » لما عدا الأركان فتخصيص من استيقن به أولى من العكس.
ولكن لقائل أن يقول: إنّ قوله « من زاد » معناه: من زاد زيادة غير مبطلة فعليه كذا، وليس المقصود من الرواية: بيان عدم الابطال، بل المقصود: بيان حكم موضوع الزيادة الغير المبطلة، وحينئذٍ فلا معارضة بين ذلك، وبين قوله « من استيقن ».
هذا ولكن في سند « من استيقن » ضعف يغني عن التعرّض بعلاج معارضاته، فلم يبق في المقام معارضة إلاّ بين « لا تعاد » وما دلّ على مبطلية مطلق الزيادة، وقد مرّ حكومته عليها.
فظهر أنّ مقتضى الروايات كون الزيادة العمدية مبطلة والسهوية غير مبطلة.
مسألة
إذا ثبت جزئية شيء أو شرطيّته فهل يقتضي الأصل الجزئية والشرطية المطلقتين حتى إذا تعذّر الجزء أو الشرط سقط الواجب، أو لا يقتضي إلاّ اعتبارهما في حال التمكّن فلو تعذّر لم يسقط المقدور من المشروط والمركّب؟ قولان:
القول الأوّل: أصالة البراءة من الفاقد، ولا يعارضها إستصحاب وجوب الباقي، لأنّ وجوبه كان مقدّمياً لوجوب المجموع الساقط وجوبه يقيناً لتعذّر بعضه فما نشأ منه أيضاً ساقط، وانّما الشك في الوجوب النفسي الحادث بعد التعذّر على تقدير ثبوته واقعاً.
نعم إن ثبت إطلاق يقتضي بقاء وجوب الباقي بعد تعذّر ذلك الشرط أو الجزء، ثم ثبت الوجوب لم يبق مجرى للأصل المذكور، كما لو فرض أنّ الأمر أوّلاً تعلّق بالباقي على نحو الاطلاق وثبت تقييده ذلك الاطلاق في حال التمكّن من ذلك الشرط أو الجزء، ومن هذا القبيل الأوامر المتعلّقة بالصلاة عند من يقول: بكونها اسماً للأعم من الصحيح والفاسد بالنسبة إلى الاجزاء الغير المقوّمة.
ولكن هذا الكلام يتمّ إذا لم يكن للقيد إطلاق يقتضي الجزئية على نحو الاطلاق، فانّه يقدّم حينئذٍ على إطلاق الآمر بالباقي، وذلك نظير الأجزاء والشرائط الثابتة بالأوامر الغيرية.
فان قلت: كيف يتعقّل إطلاق لمثل هذه الأوامر في بيان الجزئية مع أنّ ثبوت مدلولها وهو الوجوب مقيّد بحال الامكان؟ مثلاً لو قال: صلّ ثم قال: إقرأ فاتحة الكتاب وعلمنا: أنّ الوجوب المتعلّق بالقراءة غيريّ، لا يمكن بذلك الأمر إثبات إطلاق الجزئية مع تقيّده بحكم العقل بحال الامكان.
قلت: تقييد الأمر المطلق بالجزء بالامكان ليس تقييداً مولوياً، بل هو تقييد عقلي من قبيل المانع عن ثبوت الحكم، وهو لا ينافي وجود المقتضي لبقاء الحكم ونقول يفهم من إطلاق الأمر بالقراءة وعدم تقييده لفظاً بحال التمكّن أنّ جزئية هذه للصلاة ليس في حال دون حال، بل ماهية الصلاة دائماً لا تكون خالية منها باطلاقه يقتضي الجزئية على نحو العموم.
وتوضيحه: أنّ التقييد بالامكان راجع إلى معذورية المكلّف، وهو يجامع وجود المقتضي لثبوت الحكم وعدمه وهذا التقييد اذا ثبت عقلاً لا يعارض بعد كونه مجامعاً لثبوت المقتضي وعدمه ما دلّ على ثبوت المقتضي لثبوت الحكم وفي حال عدم الامكان، وإن لم يكن فعلياً لمانع التعذّر، وإطلاق الأمر بالجزئي لفظاً يقتضي أن يكون المقتضي لثبوت الجزئية والوجوب الغيري ثابتاً حتى حال التعذّر، لأنّ بيان انحصار المقتضي بحال التمكّن من القيد لا يكون عرفاً إلاّ بالتقييد بالامكان، فعدم التقييد بالامكان مع إحراز كون الاطلاق وارداً في مقام البيان دليل على أنّ المقتضي لا يكون مخصوصاً بحال التمكّن، فلا يكون الجزئية مخصوصة بحال التمكّن، والتقييد العقلي كما عرفت لا يعارض هذا الاطلاق.
بل يمكن أن يقال: إنّ التقييد هنا ليس الاّ تقييداً واحداً متعلقاً بالأمر بذي المقدّمة والتقييدات المتصورة في الأوامر الغيرية الحاصلة منه كلّها تابعة لتقييد ذلك الأمر النفسي المتعلّق بذي المقدمة فتأمّل.
فتلّخص ممّا ذكرنا أنّه إذا لم يكن إطلاق يقتضي الوجوب بعد تعذّر الجزء أو الشرط، كان الأصل سليماً عن المعارض، ومن هذا القبيل ما لو ثبت أجزاء المركّب بالأوامر الغيرية، فانّ الكل المركّب منها سقط بسقوط البعض فيسقط تلك الأوامر، وليس لها إطلاق بالنسبة إلى حال تعذّر بعض الأجزاء، لأنّ الوجوب الغيري بوجوب الكل المركّب ممّا تعذّر بعضه لا يعقل بقاؤه حال تعذّر ذلك البعض، لسقوط الأمر بذي المقدّمة أعني ذلك الكل المركّب كما هو واضح.
والقول الثاني: الاستصحاب ويقرّر بوجوه أربعة:
الأوّل: أن يستصحب الوجوب الكلّي المتعلّق بالباقي الذي هو قدر مشترك بين الوجوب الغيري السابق أعني الموجود حال تمكّن الجزء أو الشرط، والوجوب النفسي الثابت له حال التعذّر إن كان ثابتاً في الواقع، وصحّة هذا الاستصحاب مبتنية على صحة استصحاب الكلي إذا كان الشك في بقائه ناشئاً من الشك في قيام فرد آخر من الكلي مقام الفرد الذي كان الكلي موجوداً في ضمنه وقد تحقّق ارتفاعه، كالشك في وجود حيوان ناطق في الدار بعد اليقين بأنّ زيداً خرج منه، للشك في أنّه دخل عمرو في الدار مقارناً لخروج زيد أم لا؟ وليس هذا من قبيل إستصحاب السواد الموجود في ضمن السواد الشديد بعد القطع بزوال الشدّة والشك في تبدّله بالفرد الآخر وهو السواد الضعيف أو إنعدامه رأساً ممّا يكون الفرد الباقي عين الفرد المتقدم يقيناً بحسب العرف، كما لا يخفى.
هذا كلّه مع أنّه يمكن أن يقال: أنّ الوجوب الكلّي القدر المشترك بين الوجوب النفسي والغيري لا أثر له هنا، وثبوته في الظاهر أيضاً لا يترتّب على مخالفته عقاب فيما نحن فيه، لأنّ الوجوب المردّد بين النفسي والغيري لا يترتّب عليه العقاب إذا كان هناك وجوب نفسي آخر يتردّد هذا الوجوب بين النفسية والغيرية لأجل التوصّل إلى متعلّق ذلك الوجوب الآخر.
والقول بانّه يحكم بعد ثبوت القدر المشترك بأنّه نفسي لانتفاء الغيرية قطعاً.
يدفعه أنّ ذلك مبنيّ على صحّة الاصول المثبتة.
الثاني: أن نستصحب الوجوب المطلق من غير نظر إلى الغيرية والنفسية بدعوى أنّ الثابت حال الشك - على تقدير ثبوته - عين الذي كان ثابتاً حال اليقين بالثبوت، بناءً على عدم تمايز الوجوب الغيري والنفسي عند العرف وكونهما شيئاً واحداً عندهم.
الثالث: أن نستصحب الوجوب النفسي - بناءً على أنّ الذي كان واجباً عين الباقي عرفاً - نظير استصحاب الكريّة بالنسبة إلى الماء الذي علم كثرته وشك في بقاء الكثرة بعد إنعدام بعض أجزائه.
الرابع: أن نستصحب الوجوب النفسي المردّد بين تعلّقه سابقاً بالمركّب على أن يكون المقصود جزءً له مطلقاً فيسقط بتعذّره، وبين تعلّقه به على أن يكون الجزء جزءً اعتبارياً يبقى التكليف بعد تعذّره، فانّ الأصل بقاء هذا الوجوب فيثبت به تعلّقه بالمركّب على الوجه الثاني، وهذا نظير إجراء استصحاب وجود الكر في هذا الاناء لاثبات كرية الباقي.
ويمكن أن يقال: إنّ ما نحن فيه ليس من قبيل استصحاب الكر، لأنّ المستصحب في مسألة الكر هو الكر الشخصي الموجود سابقاً، والوجوب النفسي المستصحب هنا ليس عين الوجوب النفسي السابق إلاّ إذا فرض كون المستصحب أمراً كلّيّاً، وهو القدر المشترك بين النفسيّين وهو لا يصح الاّ بالمسامحة التي سبقت الاشارة إليها في التقرير الثالث.
والحاصل: أنّ الوجوب النفسي هنا ليس أمراً واحداً مردّداً بين القابل للبقاء الذي كان في السابق موجوداً وبين ما لم يقبل البقاء، بل الموجود في الحال الثانية على تقدير وجوده غير الموجود أوّلاً.
إلاّ أن يقال: إنّ المقتضي لطلب المركّب من الباقي والجزء الذي تعذّر حصوله حال إمكانه عين المقتضي لطلب الباقي حال تعذر الجزء الآخر وبهذا اللحاظ يكون وجوب الباقي عين الوجوب السابق.
هذا ولكن صحّة هذا الاستصحاب - على تقدير اجرائه في الوجوب الشخصي -
موقوف على صحّة الاصول المثبتة.
ويدلّ على القول الثاني أيضاً قولهعليهالسلام : إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم(١) بناءً على أنّ المراد الشيء المركّب لا الكلي ولا العام الاصولي، فإنّ إرادة الكلي مخالف للظاهر، لأنّ الظاهر من كلمة « من » أنّه للتبعيض، وإذا اريد من الشيء الكلي لا يصحّ التبعيض، لأنّ الفرد ليس بعض الكلي فيحتاج إلى مسامحة وهي أن يكون التبعيض بملاحظة أنّ الفرد بعض الأفراد ويكون المراد من قوله: « فأتوا منه » فأتوا من أفراده، وكذلك إرادة العام أيضاً خلاف الظاهر، لأنّ الأمر حينئدٍ ليس بشيء واحد، بل امر بأشياء هي الاكرامات المتعلقة بالعلماء فتأمّل واحتمال كون « من » بمعنى الباء مخالف للظاهر كاحتمال كونها بيانية، بل الثاني مشكل جّداً.
ويدلّ عليه أيضاً قولهعليهالسلام : « ما لا يدرك كله الخ »(٢) .
وقد يورد عليه بأنّه يحتمل كون لفظ الكل للعموم الافرادي، لعدم ثبوت كونه حقيقة في الكل المجموعي ولا مشتركاً معنوياً بينه وبين الافرادي، فلعلّه مشترك لفظي أو حقيقة خاصة في الافرادي، فيدلّ على أنّ الحكم الثابت لموضوع العام بالعموم الافرادي إذا لم يكن الاتيان به إلاّ على وجه العموم لا يترك موافقته فيما أمكن من الأفراد.
ويجاب عنه: بأنّ كون لفظ الكل للعموم الافرادي لا وجه، لأنّ المراد بالموصول: هو فعل المكلّف، وكلّه عبارة عن مجموعه.
نعم لو قام قرينة على إرادة المتعدّد من الموصول بان اريد ان الافعال التي لا يدرك كلها كاكرام زيد واكرام عمرو وغيرهما لا يترك كلها، كان لما احتمله وجه لكن لفظ كل حينئذٍ أيضاً مجموعي لا افرادي، إذ لو حمل على الافرادي كان
____________________
(١) عوالي اللئالي: ج ٤ ص ٥٨ ح ٢٠٦.
(٢) عوالي اللئالي: ج ٤ ص ٥٨ ح ٢٠٧.
المراد ما لا يدرك شيء منها لا يترك شيء منها ولا معنى له، وفي كلامه الأخير نظر، لأنّ كون كل افرادياً أو مجموعياً لا مدخل له في ذلك، بل المناط كون العموم مسلوباً أو السلب عاماً.
والحاصل: أنّ ما لا يدرك كلّه قد يكون معناه: ما لا يدرك شيء منه، وقد يكون ما لا يدرك جميعه، وعلى الثاني لا يلزم أن يكون الكل مجموعياً، بل اللازم توجّه النفي إلى العموم المستفاد من الكل.
والحاصل: أنّ قولنا ليس كل انسان حيوان مع أنّ النفي غير عام ويكون متوجهاً إلى العموم لا يكون كل فيه مجموعياً بل هو افرادي، ولذلك أخذه المنطقيون سور القضية ومعنى القضية على تقدير أن لا يكون النفي عاماً إن قدّرنا الكل مجموعياً: أنّ ما لا يدرك مجموعة لا يترك مجموعة، وإن قدّرنا إفرادياً: ما لا يدرك كل واحد من افراده.
القول في كيفية معذورية الجاهل في مسألة القصر والاتمام والجهر وأخيه
وقد فصّلها الشيخرحمهالله في الرسالة(١) فلنوضح كلامه.
قوله: إما بدعوى كون القصر مثلاً واجباً على المسافر العالم، وكذا الجهر والاخفات الخ.
وفيه: انه مع استلزامه التصويب والدور المانعان عن تخصيص الأحكام الواقعية بالعالمين لا يدفع الاشكال، إذ لا وجه لعقاب الجاهل على مخالفة الحكم المختص بالعالم كما هو المفروض.
قوله: وإمّا بمعنى معذوريته فيه الخ. الظاهر أنّ المراد منه المعذورية الشرعية.
وحاصله: توقّف تنجّز التكليف بالواقع المجهول على حصول العلم اتّفاقاً، لا على إمكان تحصيل العلم وهذا كسابقه في عدم دفع الاشكال، ضرورة أنّه مع المعذورية الشرعية لا وجه لعقاب الجاهل.
وفيه إشكال آخر وهو أنّ عدم تنجّز التكليف الواقعي لا يستلزم إجزاء المأمور به ظاهراً عنه وسقوطه بامتثال التكليف الظاهري، هذا مع أنّ ظاهر العبارة حيث ادرج هذا الجواب في القسم الأوّل من أقسام الأجوبة: أن يكون الأمر متعلّقاً بما حكم باسقاطه، مع أنّه لا يعقل تعلّق الأمر به من حيث كونه جاهلاً ولو فرضنا إمكان تعلّق الأمر فلا أمر أيضاً، فانّ المخاطب بالاتمام هو الحاضر. اللهم الاّ أن
____________________
(١) فرائد الاصول: ص ٥٢٣.
يقال أنّه كاف في صحة الامتثال المحبوبية الواقعية ولما كان المكلّف معتقداً للأمر بفعله أغنى ذلك عن توجيه الخطاب إليه، إذ الغرض منه هو البعث والتحريك وهو حاصل لاعتقاده الأمر.
قوله: وإمّا من جهة القول بعدم التكليف الخ. هذا أيضاً لا يدفع الاشكال - بناءً على المشهور من كون العقاب على ترك الواجب الواقعي - يتوجّه عليه أيضاً ما مرّ من عدم الأمر، وعدم معقولية إجزاء إمتثال ذلك عن الأمر الواقعي.
قوله: وإمّا جهة تسليم تكليفه بالواقع الخ.
أقول: استحقاق العقاب على مخالفة الحكم الواقعي - بناءً على هذا الوجه - صحيح ومبنيّ على ما تقدّم من أنّ استحقاق العقاب على مخالفة الواقع ليس موقوفاً على وجود العلم به، بل يكفي فيه التمكّن من العلم به ولو قبل زمان وجوبه إذا قام احتمال الوجوب عند المكلّف.
ولكن يشكل الأمر لو حصل للمكلّف إلتفات - بعد الفراغ عن التمام والوقت باق - إلى أنّ الواجب هو القصر، إذ مع عدم إستمرار غفلته إلى آخر الوقت لا معنى لانقطاع الخطاب، إذ انقطاعه انّما هو بسبب عدم القدرة على الامتثال بسبب سوء اختياره، نظير من لم يذهب إلى الحج مع القافلة الأخيرة، ومع عدم استمرار غفلته لا يخرج بهذه الغفلة عن التمكّن من الامتثال.
ثم انّه بناءً على هذا الوجه: يكون التمام واجباً واقعياً لا ظاهرياً، وعلاج اشكال الأمر هو ما مرّ في الوجهين السابقين.
واعلم أنّه لمّا كان اشكال إجزاء المأمور به بالأمر الثاني عن الأمر الأوّل مطرداً في الوجوه أخّرنا دفعه فنقول: مقتضى القاعدة الأولية أن لا يجزي غير المأمور به عن المأمور به وإن كان ذلك الغير مأموراً بأمر آخر، إلاّ أنّه يعقل الاجزاء فيما إذا كان ذلك الغير مشتملاً على مصلحة يتدارك بها المصلحة التي لأجلها أمر بالواجب، لأنّ الغرض من الأمر إذا حصل وهو إدراك تلك المصلحة، لا يعقل حينئذٍ بقاء ذلك الأمر، فنقول: إنّ من الجائز أن يكون فعل التمام الصادر من الجاهل مشتملاً على
مصلحة يتدارك بتلك المصلحة ما يفوت عنه بترك القصر بحيث لو فعله في الوقت لا يبقى مورد لتلك المصلحة، حتى لو فرض التفاته إلى الواجب الواقعي في الوقت يكون فعله عليه واجباً، أو بعد الوقت يكون القضاء عليه واجباً.
فان قلت: إذا كان فعل التمام الصادر من الجاهل مشتملاً على مصلحة القصر فتكليفه في الواقع بالقصر تعييناً لا مقتضي له، إذ المصلحة المقصود - كما هو الغرض - حاصلة بأمرين فلا موجب للتضييق عليه.
والحاصل: أنّ الفعلين إذا اشتركا في حصول الغرض بهما لا موجب لتعيين أحدهما في الواقع وجعل الآخر بدلاً ظاهريّاً عنه، وإن لم يشتركا في المصلحة وحصول الغرض فلا معنى لسقوط الأمر بغير ما تعلّق هو به.
قلت: لا ندّعي أنّ فعل التمام - من حيث هو - مشتمل على مصلحة يتدارك به مصلحة القصر حتى يكون في عرض القصر ويكون مقتضاه حينئذٍ التخيير الواقعي بينهما دون البدلية عن الواقع، بل نقول: إنّ من الجائز أن يكون فعل التمام في مقام إمتثال الأمر الواقعي الذي تعلّق بالقصر في الواقع وبالتمام بزعم المكلّف مشتملاً على مصلحة بها يتدارك ما يفوت من القصر، نظير مصلحة السلوك في الامارات المجعولة طرقاً إلى الواقع تعبّداً، ولا ندّعي إشتماله على تمام تلك المصلحة حتى يقال: أنّ لازم ذلك أيضاً ليس الاّ التخيير الواقعي بين القصر والاتمام، إذ كل منهما مشتمل على المصلحة على تقدير إتيانه بداعي الامتثال، بل نقول: من الجائز أن يكون إتيانه بداعي إمتثال الأمر الواقعي مشتملاً على مصلحة يكون معها قابلاً لأن يقبله المولى بدلاً عن الواقع، لا بمعنى حصول الغرض منه بتمامه بحيث لا يبقى معه مورد للأمر الأوّل، بل بمعنى أنّه مشتمل على مصلحة يصحّ للآمر مع تلك المصلحة أن لا يرفع اليد عن الأمر الواقعي، فيجب على المكلّف حيث يلتفت إليه إمتثاله أداءً وقضاءً، ويصح له أن يرفع اليد ويقبله إمتثالاً لذلك الأمر، فيسقط ذلك الخطاب عن المكلّف لأجل حكمة رآها الآمر، فالمصلحة الموجودة في التمام هو مصلحة البدلية عن الواقع، لا مصلحة توجب الأمر به تعييناً أو تخييراً بينه وبين
القصر، نظير المواطن الأربعة، وهذا الوجه جار في الوجوه الثلاثة المتقدّمة إلاّ أنّه يشكل الالتزام بذلك في بعض الصور على الوجه الأخير، وهو ما لم يكن جهل المكلّف مستمراً إلى آخر الوقت، لأنّ بناء ذلك الوجه على سقوط الخطاب بالواقع بسبب ترك بعض المقدّمات الذي أفضى إلى ترك الواجب، ولا ريب أنّ غفلة المكلّف عن القصر بعد ترك التعلّم ما لم يستمرّ إلى آخر الوقت، أو لم يكن سبباً لفعل المسقط لا يكون مفضياً إلى ترك الواجب حتى يكون الخطاب من أوّل الأمر لعلم الآمر بخروج امتثاله بعد ترك المقدّمة اختياراً المفضي إلى الغفلة عن قدرة المكلّف ساقطاً، نظير تارك الحج مع القافلة الأخيرة، وحينئذٍ فان قلنا: إنّ هذا الفعل المأتي به في حال الغفلة مسقط عن الواجب يكون مبغوضاً، ضرورة أنّ سبب المبغوض مبغوض، ويكون في الواقع لكونه صادراً عن اختيار المكلّف منهيّاً عنه، فكيف يكون محبوباً في الواقع ومجزياً عن الواقع؟
والحاصل: أنّ فرض إشتمال التمام الموجب لسقوط القصر على المصلحة المقتضية لسقوطه مقتض لتعلق النهي به، لأنّه الذي به يفوت الواجب وينقطع الخطاب المتعلّق به. هذا مع أنّ الخطاب بالواقع منقطع حينئذٍ بعد الفراغ عن التمام لا قبله، الاّ أن يقال: إنّه ينقطع عند ترك المقدّمة الموجب لفعل هذا المسقط، لأنّه من ذلك الحين يخرج الامتثال عن قدرة المكلّف كما مرّ.
قوله: والتزام أنّ غير الواجب مسقط عن الواجب الخ.
قد مرّ أنّ الوجوه السابقة أيضاً لم يكن المأتي به في حال الجهل مأموراً به فعلاً بناءً عليها، إلاّ أن يكون المقصود من عدم الوجوب هنا عدم المحبوبيّة الواقعيّة، ولا ريب أنّه معه يشكل سقوط الواجب به.
قوله: نعم قد يوجب الخ.
المقصود هنا ليس النهي من جهة كونه مشتملاً على المصلحة يكون معه سقوط الواقع، بل المراد النهي من جهة التمانع في الوجود الخارجي باعتبار عدم توسعة الزمان لهما.
قوله: فقد كلّفه بالقصر والاتمام على تقدير معصيته في التكليف الخ.
توضيح مرام هذا القائل هو أنّ التكليف بالقصر مطلق بالنسبة إلى المعصية في ذلك التكليف بالمعنى الذي يأتي ومع فرض تحقّق شرائط تنجّزه التي منها تمكّن المكلّف من تحصيل العلم به مع قيام احتمال وجوبه يكون متنجّزاً والتكليف بالاتمام مرتّب على معصيته في التكليف بالقصر، إن قلنا: بأنّ الشرط المتأخّر ممكن عقلاً، فالتكليف بالاتمام في أوّل الوقت مشروط بعصيان المكلّف في التكليف بالقصر تركه له في تمام الزمان المضروب له، فهذا الشرط إن كان حاصلاً في زمان حصوله الذي هو الزمان المتأخّر عن زمان حصول المشروط يكون المشروط حاصلاً في زمانه الذي هو الزمان المتقدم على زمان تحصيل الشرط والاّ فلا، وإن قلنا: بأنّ الشرط المتأخر غير معقول يكون التكليف مشروطاً بكون المكلّف في أوّل الوقت ممّن يعصي تكليفه بالقصر، وعلى التقديرين تحقّق المعصية في تمام الوقت كاشف عن تنجّز التكليف بالاتمام، لكنها على الأوّل نفس الشرط، وعلى الثاني منشأ لانتزاع الشرط أعني الأمر الانتزاعي الذي تحقّقه منوط ومربوط بتحقّق منشأ انتزاعه.
قوله: وسلك هذا الطريق في مسألة الضد الخ.
أقول: صحّة العبادة فرع الأمر بها، وحيئنذٍ فاذا فرضنا: أنّ الواجبين المتزاحمين كان أحدهما أهمّ كان هو المأمور به لا غير، فصحّة غير الأهمّ لا معنى له، ضرورة أنّ الأمر به عيناً غير موجود، لقبحه مع الأمر بالأهم وتخييراً كذلك، لقبح تجويز غير الأهم مع استلزامه فوت الأهم. وهذا القائل لمّا كان الترتب في الأمر بالشيئين عنده ممكناً بنى على أنّ التكليف بغير الأهم مشروط إمّا بأمر متأخّر عنه وهو عصيان التكليف بالأهمّ، أو مقارن له وهو كون المكلّف ممن يعصي لذلك التكليف.
قوله: ويرده الخ.
توضيح مرامه: أنّ التكليف بالقصر هنا وبالأهم في مسألة الضدّ لعدم اشتراطه بشىء يكون منجّزاً، والتكليف بالاتمام وبغير الأهمّ بحصول شرط في زمانه أيضاً
مطلق فكل من التكليفين حاصل في زمان الآخر ولا ترتّب بينهما.
والحاصل: أن التكليف المشروط إذا حصل شرطه يكون منجّزاً، والمفروض أنّ التكليف الآخر وهو التكليف بالقصر هنا وبالاهم في الضد مطلق فيلزم التكليف بالمتنافيين في زمان لا يسع لهما في مسألة الضد، وكذلك هنا في آخر الوقت، فالاشتراط المذكور لا يرفع ذلك إلاّ إذا كان حدوث التكليف الثاني بعد تحقّق المعصية.
نعم فائدة هذا الاشتراط إختصاص هذا المحال بصورة كون المكلّف عاصياً بالنسبة إلى التكليف المطلق وعلى تقدير عدم الاشتراط لزم ذلك مطلقاً.
وقد ذكر لصحّة الترتّب وجوه اخر:
أحدها: أنّ التكليف الثاني لمّا كان معلّقاً على أمر اختياري للمكلّف وهو معصية التكليف الأوّل، أو على أمر حصوله باختيار المكلّف وهو كون المكلّف ممّن يعصي التكليف الأوّل جاز تنجّزه عند حصول شرطه من لزوم إرادة إيجاد المتنافيين في زمان لا يسع لهما لا يمنع عن صحة التكليف، لأنّ التكليف بالمحال إذا كان ناشئاً من اختيار المكلّف لا ضير فيه.
وفيه: أنّه لا فرق في قبح التكليف بغير المقدور بين ما إذا كان سبب الخروج عن القدرة هو المكلّف خارجاً عن القدرة في نفسه، مع أنّ خروج ايجاد المتنافيين عن القدرة انما هو لذاته، والمكلّف انّما هو سبب تنجّز هذا التكليف، لكون أحد التكليفين مشروطاً بأمر اختياري له. والظاهر أنّ من يجوّز التكليف بغير المقدور إذا كان ناشئاً من اختيار المكلّف يريد جواز التكليف بما يكون خروجه عن القدرة باختيار المكلف، لا ما يكون سبب حدوثه هو المكلّف، لكون شرطه اختيارياً.
الثاني: أنّ التكليف المشروط مرتبته متأخّرة عن التكليف المطلق، وليس أحدهما في مرتبة الآخر، ومعه لا مانع من تحقّقهما.
بيان ذلك: أنّ التكليف الأوّل لا يصحّ أن يكون مشروطاً بوجود متعلّقه أو مشروطاً بعدمه، لأنّ الأوّل يرجع إلى إرادة ايجاد الشيء بشرط وجوده، والثاني
يرجع إلى إرادة ايجاد الشيء بشرط عدمه، فالاشتراط يرجع إمّا إلى طلب الحاصل أو طلب المحال، واذا لم يصح تقييد الأمر الأوّل بأحد القيدين لم يكن فيه إطلاق بالنسبة إليهما، لأنّ الاطلاق انّما يتحقّق بعدم الاشتراط حيث كان الاشتراط سائغاً، وأمّا مجرّد عدم الاشتراط لا يوجب الاطلاق، ولا فرق فيما ذكرنا من عدم صحّة الاشتراط بين أن يكون شرط تحقّق التكليف هو وجود ذلك الفعل في الزمان الثاني إن قلنا بصحة الشرط المتأخّر، أو كون المكلّف حال التكليف ممّن يفعل الفعل في الزمان الثاني، وبين أن يكون الشرط في تحقّق التكليف وجود متعلّقه على نحو سائر الشرائط التي وجودها قبل تحقّق المشروط، وذلك واضح.
إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ التكليف الثاني لما كان مشروطاً بأمر لم يكن التكليف الأوّل مشروطاً به لم يكن في مرتبة التكليف الأوّل، والتكليف الأوّل لمّا لم يصحّ اشتراطه بما شرط به الثاني لم يكن باطلاقه ثانياً في مرتبة التكليف الثاني، لأنّ ثبوته باطلاقه فرع الاطلاق، وقد عرفت انه لا اطلاق له بعدم صحّة اشتراطه بهذا الشرط فليس شيء من التكليفين ثابتاً في مرتبة الآخر والتكليف بأحد المتنافيين مع ثبوت التكليف بالآخر لا يصحّ إذا لزم منه ثبوت أحد التكليفين في مرتبة الآخر وقد عرفت أنّ ذلك لا يلزم فيما نحن فيه.
وفيه: أنّ عدم صحّة اشتراط التكليف الأوّل بوجود متعلّقه انّما يمنع عن تحقّق الاطلاق اللفظي الذي يرجع إليه عند الشك في بعض الصور، ولكنه لا يمنع عن وجود التكليف حال ثبوت التكليف الثاني، ضرورة أنّ التكليف الأوّل إذا ثبت لا يسقط الاّ بمضيّ زمانه أو بالاطاعة والمفروض أنّه في حال ثبوت التكليف الثاني لم يتحقّق شيء من الأمرين، لأنّ اشتراط التكليف الثاني بمعصية الأوّل لم يكن على وجه يوجب عدم حدوثه الاّ بعد تحقّق المعصية، بل كان ثبوتها في الزمان المتأخّر سبباً لحدوثه في الزمان المتقدم، وهو ثابت ومع ثبوته يلزم من التكليف الثاني التكليف بأحد المتنافيين في مرتبة التكليف بالآخر.
نعم لو كان لازم حصول شرط التكليف الثاني سقوط الأوّل بحصول ما يسقطه
لم يكن مانع عن صحته وقد عرفت انه لا يلزم ذلك.
الثالث: أنّ التكليف بالمتنافيين انّما يكون قبيحاً إذا لزم منه إرادة الجمع بينهما، وإذا لم يلزم منه ذلك فلا مانع منه، لأنّ المانع من التكليف بذلك ليس إلاّ التكليف بغير المقدور، والخارج عن قدرة المكلّف هو الجمع بينهما والتكليف بأحد المتنافيين حال التكليف بالآخر إنّما يلزم منه إرادة الجمع إذا كان كلاهما مطلقين، وأمّا مع تقييد الثاني بعدم ايجاد المكلّف متعلّق الأوّل لا يلزم منه ذلك.
بيان ذلك: أنّ لازم مطلوبية الجمع وقوع كلّ منهما في الخارج على صفة المطلوبية وإن كان في حال وقوع الآخر لو فرض إمكان الجمع ووقوعه، واللازم على تقدير تقييد أحد الأمرين بعدم وقوع متعلّق الآخر في الخارج منتف، ضرورة أنّ مع وقوع ما يكون عدمه شرطاً في تحقّق التكليف بالآخر، يكون وقوع الآخر على غير صفة المطلوبية لفقد شرط مطلوبيته.
وإن شئت التوضيح فافرض الترتّب في التكليفين المتعلقين بما يمكن الجمع بينهما، مثلاً لو قال الآمر: صم يوم الخميس وكن في المسجد في ذلك اليوم من أوّله إلى آخره، إذا تركت الصيام فيه فانّه على تقدير الجمع بين الصيام والدخول في المسجد، لا يقع الثاني منهما على صفة المطلوبية فانّ مطلوبيته مقيّدة بعدم فعل الصيام.
فان قلت: إنّ مع فرض تنجّز التكليف المشروط بالشرط المتأخّر لأنّ تحقق شرطه الذي هو معصية التكليف الأوّل في حال امتثال التكليف الثاني يكون التكليف الأوّل باقياً، لأنّه لم يحدث بعد ما يوجب سقوطه من مضيّ زمانه أو امتثاله، ولازم بقائه حينئذٍ وجود متعلّقه على صفة المطلوبية في هذا الحال وهو الشيء حال عدمه، والمفروض أنّ متعلق التكليف الثاني ايضاً إذا وجد في هذا الحال يوجد على صفة المطلوبية، لأنّ شرط مطلوبيته الذي هو عدم وجود متعلّق الأوّل الحاصل، فمانع التكليف بالمتنافيين وهو إرادة الجمع متحقّقه في هذا الفرض، غاية الأمر أنّ تحقّقه مبنيّ على أمر محال وهو تحقّق التناقض.
قلت: لازم المحال محال، وتوضيحه: أنّ مطلوبيّة الثاني مع وجود متعلّق الأوّل انّما هي مرتّب على أمر محال وهو عدم متعلّق الأوّل في حال وجوده والمرتّب على المحال محال، ومعنى بقاء التكليف الأوّل في حال تحقّق شرط التكليف الثاني ليس معناه مطلوبية الفعل في حال عدمه مقروناً بعدمه، بل معناه مطلوبية عدم استمرار العدم وبقاء هذا التكليف مع فرض عدم تحقق متعلّقه انّما هو لكون متعلّقه باقياً على اختيار المكلّف ومقدوراً له في هذا الحال، فهذا الحال لو فرض إمكانه أيضاً لا يكون وقوع الفعل معه على صفة المطلوبية والحاصل ان في هذا الفرض يمكن منع مطلوبية كل من متعلّقي الأمرين.
فإن قلت: إذا كان التكليف الثاني مشروطاً بعدم متعلّق التكليف في الزمان المتأخّر، فمتى يتحقّق تنجّزه ومتى يعلم المكلّف تنجّز ذلك التكليف؟
قلت: أمّا تنجّزه فان أمكن اشتراط وجود شيء بأمر متأخّر عنه فهو قبل مضيّ زمان التكليفين، وكذلك إن لم يكن لأنّ الشرط حينئذٍ الأمر المتحقّق قبل تحقّق التكليف المنتزع من العدم اللاحق، وأمّا العلم به فانّما يحدث إذا بنى المكلف على معصية الأوّل، وعلم أنّه يخالفه، ونظيره في ترتّب التنجّز على اختيار المكلّف ما لا يعقل الشك في صحّته وهو التكليف المعلّق على أمر مباح، كأن يقول المولى: يجوز لك الأكل، وإن تركت الأكل فاشتر اللحم في الزمان الذي كنت تأكل لو أخّرت الأكل.
فان قلت: هذا التوجيه لا يتمّ في مسألة الضدّ، لأنّ مطلوبية غير الأهمّ ليس مقيّداً بحال عدم فعل الأهم، غاية الأمر أنّه لمّا كان الأهمّ مطلوباً منع أهميّة الأهمّ عن التكليف بغير الأهمّ.
قلت: إطلاق مطلوبيّة غير الأهم لا يلازم إطلاق طلبه لجواز مانع عن الاطلاق في الطلب.
والحاصل: أنّ اطلاق التكليف بغير الأهمّ لاستلزامه أحد الأمرين من التكليف بالمتنافيين، أو ترجيح غير الأهم على الأهم كان قبيحاً، ولأجل ذلك
لا يكون مطلوبيّته على نحو الاطلاق وان كان محبوبا مطلقا، والترتيب الذي ادّعيناه انّما هو في المطلوبية دون المحبوبية، هذا غاية ما يمكن أن يقال في تصحيح الأمر بالمتنافيين على وجه الترتيب، وأمتنها الوجه الأخير الذي هو من أفكار السيّد الاستاذ(١) .
ثم اعلم أنّ المانع من الجمع بين التكليف بالقصر والاتمام إمّا أن يكون إرادة المتنافيين في زمان لا يسع لهما، وقد مرّ انه لا يلزم ذلك مطلقاً وانّما هو في آخر الوقت، ومرّ أيضاً أنّ التكليفين ان ثبتا على وجه الترتيب لا يلزم من إجتماعهما المانع المذكور.
وإمّا أن يكون المانع عدم التخيير بينهما ووحدة التكليف، بيانه: أنّ مع العلم بأنّ الجاهل ليس تكليفه في الواقع إلاّ أحد الأمرين من القصر والاتمام بمعنى أنّه لايراد منه الجمع، وليس أيضاً مخيّراً بينهما فكيف يتصوّر أن يكون مكلّفاً بهما؟ والتزام الترتّب على تقدير الغفلة يدفع هذا الاشكال، لأنّ المعلوم من أدلّة إتّحاد تكليف الجاهل والعالم ليس إلاّ أنّ الجاهل مكلّف بالقصر، ولا يكون مخيّراً بين القصر والاتمام، وأمّا انّه ليس مكلّفاً بالاتمام تكليفاً مرتّباً على عصيان التكليف بالقصر فليس معلوماً، ولا ريب أنّه مع التزام التكليف بالاتمام بهذا الوجه لا يلزم عدم تكليف الجاهل بالقصر ولا كونه مخيّراً بينه وبين الاتمام.
فان قلت: على هذا التقدير أيضاً لا يكون تكليف الجاهل والعالم متّحداً، لأنّ المفروض أنّ الجاهلي مكلّف بشيء يخصّ به.
قلت: دليل الاتّحاد ليس إلاّ أدلّة بطلان التصويب وهي لا تقتضي إلاّ أنّ كل ما ثبت في حق العالم ثابت في حق الجاهل على النحو الذي ثبت في حق العالم، وأمّا عكسه وهو أنّ كلّ ما ثبت في حق الجاهل فهو ثابت في حق العالم فلا تدلّ عليه.
____________________
(١) لا يوجد لدينا كتاب السيد المجدد الشيرازي.
نعم بقي شيء وهو أنّه على تقدير تعقّل الترتيب فلا يقتضي كون إمتثال التكليف الثاني مجزياً عن الأوّل، خصوصاً إذا اريد منه اسقاط الاعادة، ضرورة أنّه مع التفات المكلّف بعد الاتمام إلى وجوب القصر وبنائه إلى القصر ما لم يقم دليل على سقوط ذلك التكليف، لا يكون شرط التكليف الثاني موجوداً، فضلاً عن إقتضاءه إمتثاله الإجزاء بالنسبة إلى التكليف الأوّل.
والحاصل: أنّ إجزاء إمتثال أحد التكليفين عن الآخر غير معقول، وعلى تقدير تعقلّه لا يعقل هنا بالنسبة إلى الاعادة في بعض الصور إذا فرض إلتفات المكلّف إلى التكليف وبنائه على امتثاله، فان هذا البناء كاشف عن عدم تنجز التكليف الثاني، وتوجيه الإجزاء - بالوجه الذي مرّت الاشارة إليه في الوجوه السابقة - يوجب الغناء عن هذا الوجه الذي اختلف في معقوليته. هذا مع أنّ اختصاص الجاهل بالخطاب معلّقاً على معصية الخطاب الأوّل على وجه لا يرفع جهله غير معقول، ولذلك التزمنا في بعض الوجوه السابقة إلى أنّ المحبوبية كافية في صحة العبادة لو فرضنا حصول الفعل بجميع القيود المعتبرة فيه التي منها قصد التقرّب.
فان قلت يمكن تصوير الإجزاء بوجه آخر غير ما مرّت الاشارة إليه وهو أنّ الجاهل مكلّف بمطلق الصلاة ومكلّف بايجادها قصراً.
قلت: إن اريد من إجزاء فعل التمام إجزاء عن التكليف بمطلق الصلاة فهو يحصل، وإن لم يتعلّق به بخصوصه تكليف أصلاً، وإن اريد منه إجزاؤه عن التكليف بالقصر فلا يحصل وإن كلّف به بخصوصه أو معلّقاً على معصية التكليف بالقصر نعم يلزم من إجزائه عن التكليف بمطلق الصلاة سقوط الأمر بالقصر لعدم بقاء مورد له هذا مع فساد الوجه من أصله، لاقتضاء مخالفة تكليف الجاهل لتكليف العالم لأنّ تكليف الجاهل بالقصر حينئذٍ لكونه أحد أفراد المأمور به واشتماله على مزيّة ليس في مطلقه، ولا ريب في أنّ تكليف العالم ليس بمطلق الصلاة وبايجادها قصراً، ولذا لا يحصل الاجزاء بفعل التمام فتدبّر لئلا تتوهّم المنافاة بين هذا الكلام وما مرّ من إختصاص الجاهل بالتكليف بالتمام مرتّباً على التكليف
بالقصر لا يلزم منه التصويب.
القول في الفحص
قوله(١) : وإن كانت الشبهة وجوبية فمقتضى أدلّة البراءة حتى العقل كبعض كلمات العلماء عدم وجوب الفحص أيضاً.
أقول: أمّا دلالة الأدلّة اللفظية على عدم وجوبه فلأنّ إطلاقها يقتضي كون الجهل عذراً حتى مع التمكّن من رفعه، فانّ قولهعليهالسلام : كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي(٢) ، يقتضي الاطلاق عند عدم وصول النهي إلى المكلّف، ومثله قوله: رفع ما لا يعلمون(٣) ، يعمّ ما يمكن تحصيل العلم به وما لا يمكن، وكذا قولهعليهالسلام : الناس في سعة ما لا يعلمون(٤) .
نعم مثل قولهعليهالسلام : ما حجب اللّه علمه عن العباد(٥) ، يمكن المناقشة في دلالتها: بأنّ الحجب ليس من اللّه تعالى مع القدرة على الاستعلام ولو نوقش في شمولها للشبهات الموضوعية، لأنّ بيانها ليس وظيفة الشارع فالحجب الحاصل فيها غير مستند اليه، كان عدم دلالته أوضح، وأمّا مخالفتها في الشبهات الحكمية فالاجماع على وجوب الفحص والأخبار الدالّة على وجوب التعلّم بعد معلومية عدم مطلوبية التعلّم في نفسه.
وأمّا العقل فحكمه بعدم وجوب الفحص مع التمكّن منه مع قطع النظر عن كونه حرجاً لكثرة موارد الشبهة فممنوع بل يمكن دعوى حكمه بوجوب الفحص هنا بالأولويّة، لأنّ وظيفة الشارع بيان كلي التكليف والمفروض بيانه، وأمّا بيان
____________________
(١) فرائد الاصول: ٥٢٤.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٣٧.
(٣) المحاسن: ص ٣٣٩.
(٤) المحاسن: ص ٤٥٢ ح ٣٦٥ وفيه « يعلموا ».
(٥) التوحيد: ص ٤١٣ ح ٩.
الموضوعات وجزئياتها فالمرجع فيه العرف وأهل خبرتها.
ثم إنّه لو فرضنا عدم حكم العقل بشيء فهل يجب مع قطع النظر عن الأدلّة اللفظية الاحتياط أو لا يجب؟
قد يقال: إنّ مع عدم حكم العقل بشيء لا يكون بيان لثبوت التكليف، ومعه فقاعدة قبح التكليف بلا بيان يقتضي البراءة.
والحاصل: أنّ العقل وإن لم يحكم مع قطع النظر عن الكلّية المذكورة بشيء لكنه بعد ملاحظتها يحكم بالبراءة، إذا المفروض عدم البيان لا عقلاً ولا نقلاً.
ويمكن المناقشة فيه: بأنّه كما لا يجوز على المولى أن يعاقب العبد بدون الحجّة، كذلك لا يجوز على العبد المخالفة بدون العذر، وحينئذٍ فان علم في مورد الشك في ثبوت الحكم أنّه معذور في المخالفة لو ثبت في الواقع يجوز له المخالفة الاحتمالية، وإن علم بعدم المعذورية لا يجوز له، وكذلك الأمر لو شك في المعذورية، لأنّه لا يقطع بعدم ترتّب الضرر على المخالفة، لأنّه مع كونه غير معذور يستحقّ العقاب والمفروض انّه شاكّ في المعذورية.
ولا ريب أنّه مع الشك في ترتّب الضرر وعدمه يجب الاحتياط تخليصاً عن الضرر المحتمل.
ودعوى انه مع الشك في المعذورية لا يثبت البيان فيقبح على المولى العقاب.
مدفوعة بأنّ مع الشك في المعذورية شاكّ في تمامية حجّة المولى وعدم تماميته، ومع الشك في عدم تمامية حجة المولى شاكّ في العقاب، ضرورة أنّ مع تمامية الحجّة في الواقع يستحقّ العقاب.
والحاصل: أنّ الشك في تمامية الحجة وعدمها إن كان معقولاً كان الواجب الاحتياط في مورد الشك، نعم لو قلنا بأنّ تماميّة الحجّة ليست من الامور التي يدخلها الشك، لأنّ المكلّف إمّا قاطع بتماميّة الحجّة وإمّا قاطع بعدمها، كان الحكم في الشك في المعذورية هو البراءة.
ولكن هذه الدعوي في محلّ المنع، لأنّ الواجب على المولى رفع عذر المكلّف في
المخالفة بحيث يصدق على مخالفته أنّه عصى المولى، لأنّ حجّة المولى في مقام المؤاخذة ليست الاّ معصية العبد، وحيئنذٍ فان شكّ العبد في أنّ المخالفة الاحتمالية على تقدير مصادفتها الواقع تعدّ معصية لعدم كونه معذوراً أم لا لكونه معذوراً يشك في صحّة مؤاخذة المولى لوجود الحجّة وعدمها لعدمها.
والحاصل: أنّ حجّة المولى في مقام المؤاخذة ليست إلاّ المعصية ، وحجّة العبد عدمها للمعذورية، والشك في أحدهما مستلزم للشك في الآخر.
فإن قلت: لازم ذلك وجوب الاحتياط بعد الفحص أيضاً، إذ بقاء الشك بعده في ثبوت التكليف وعدمه يلزمه الشك في المعذورية المستلزم للشك في تمامية الحجة.
قلت: مجرّد الشك في ثبوت التكليف في نفس الأمر لا يوجب الشك في المعذورية، وانّما الموجب له في صدق المعصية على المخالفة الاحتمالية على تقدير المصادفة، والمخالفة بعد الفحص لا تعدّ معصية عند العقلاء قطعاً، ومع القطع بعدم المعصية يقطع بعدم العقاب.
وهذا معنى ورود قاعدة قبح العقاب بدون البيان على قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، وخلاصة ما ذكرنا أنّ إرادة المولى من العبد - فعل شيء أو تركه فعلاً - لا يجوز إلاّ في مورد يحكم العقل والعقلاء: بأنّه حجّة تامّة واتماميّة حجّته قد يكون بعلم العبد بثبوت التكليف في الواقع، وقد يكون بقيام الطريق على ثبوته وقد يكون بقيام الاحتمال مع حكم العقلاء: بأنّه لا يكون المخالفة الاحتمالية هنا سائغاً وأنّه لا يكون العبد هنا معذوراً - كما في الشاكّ في التكليف قبل الفحص في الشبهات الحكمية -، والبيان في هذه الصورة هو حكم المعذورية على تقدير ثبوت التكليف في الواقع، وإذا فقد ذلك فلا يجوز للمولى أنّ يريد منه الامتثال فعلاً وأن يعقابه على ترك الامتثال - كما في مورد الشك بعد الفحص -.
وأمّا العبد فإن قطع بأنّه لا يريد المولى منه شيئاً فعلاً فيجوز له المخالفة - كما في مورد الشك بعد الفحص - وإن قطع بأنّه يريد منه الموافقة إمّا للعلم بالتكليف، أو
لقيام الطريق، أو لعدم المعذورية، يجب عليه الموافقة ولا يجوز له المخالفة، والقطع في مورد الشك القطع بانه لو ثبت التكليف في الواقع يكون امتثاله الفعلي مراداً، ولو شك في أنّ التكليف لو ثبت في الواقع يريد الموافقة لانه معذور أو لا يريد لأنّه غير معذور(١) فيجب الاحتياط.
فان قلت: إنّ الفحص في موارد الشبهات الموضوعية لا يرفع احتمال عدم المعذورية، لأنّ بيان التكليف على ما هو وظيفة الشارع حاصل.
قلت: بيان الحكم الكلّي ليس الاّ بمنزلة كلية الكبرى التي لا ينتج ثبوت الحكم في مورد الشبهة إلاّ بعد إثبات الصغرى الموجبة لإدراج المشتبه في موضوع الكبرى المذكورة فهي لا يكون بياناً لحكم المشتبه، وحينئذٍ فالعقاب على مخالفة الحكم عند الجهل بالموضوع عقاب بلا بيان، وكما أنّ الشك بعد الفحص لا حكم له في الشبهات الحكمية، كذلك لا حكم له في الشبهات الموضوعية، ولا فرق بينهما عند العقلاء في كون الجهل عذراً. نعم الحكم بالمعذوريّة قبل الفحص محلّ إشكال.
بل الانصاف: أن أصل الحكم بعدم وجوب الفحص مشكل، لأنّ العقل عرفت حاله، والاجماع في محلّ المنع، ويظهر ذلك بمراجعة ما حكاه المصنّف والأدلّة اللفظية يمكن أن يقال: أنّها واردة في مورد حكم العقل وليس ذلك بعيداً وإن كان مخالفاً لظواهرها، فالمعتمد في المسألة ظواهر الأخبار المؤيّدة بالشهرة بل الاجماع ظاهراً.
قوله وأمّا عدم وجوب الزائد فللزوم الحرج الخ.
يمكن أن يقال: إنّ اللازم بحكم العقل ليس إلاّ الفحص على وجه يحصل اليأس عن وجدان الدليل ومع حصوله لا يجب الفحص والمخالفة إن حصلت من ترك الاحتياط لا يوجب استحقاق العقاب لأنّها لا تعدّ معصية وحينئذٍ فلا حاجة في نفي وجوب الفحص بعد اليأس إلى المراجعة إلى أدلّة الحرج وغيرها.
____________________
(١) الظاهر هنا، سهو القلم والصحيح هكذا: « يريد الموافقة لأنّه غير معذور، أو لا يريد لأنّه معذور ».
تمت هذا ما وصل الينا من افادات جد الأكرم السيّد المحقّق العلامة السيّد السند السيّد محمّد الاصفهاني رفع اللّه مقامه في مبحث البراءة.
ولقد صحّحنا هذا الكتاب من كتاب حجّة الاسلام والمسلمين وآية اللّه في الأنام الحاج الشيخ محمّد حسين الاصفهاني أصلاً وبالنجف مسكناً في السنة ١٣٥٣.
رساله في تقوّي السافل بالعالي
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه ربّ العالمين وصلّى اللّه على محمد وآله الطاهرين ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين الى يوم الدين.
مسألة: اختلفت كلمات المتأخّرين(١) في اعتبار عدم اختلاف الماء سطحاً في اعتصامه بالكثرة على أقوال. والأجود تقديم قضية الأصل، ثم التعرّض لما تقتضيه حجج الأقوال.
فنقول: قد يقال: إنّ قولهعليهالسلام : « إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء »(٢) يدلّ على اقتضاء الماء بطبعه التنجس بالملاقاة، وإلاّ لم يكن عدم التنجس مستنداً الى الكرّيّة، بل الى عدم المقتضي له، مع أنّ القلّة أمر عدميّ لا يعقل مدخليّته في النجاسة إلاّ لكونه مساوقاً لعدم المانع، فاذا تحقّقت الملاقاة المقتضية لتنجس الماء وجب البناء على مقتضاها الى أن يثبت المانع: إمّا لكفاية الشكّ في ثبوت المانع في العمل على المقتضى، أو لأنّ الأصل عدم وجود المانع، وعدم جعل المانعيّة إلاّ فيما ثبتت مانعيّته.
____________________
(١) المنتهى: في تحديد الكر، ج ١ ، ص ٧، س ١٧، ومدارك الاحكام: في مقدار الكر، ج ١، ص ٤٧ - ٤٩، والذخيرة: في مقدار الكر، ص ١٢١ و ١٢٢ و س ٤٣.
(٢) وسائل الشيعة: ب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد ح ٢، ج ١، ص ١١٧.
لكن يمكن أن يقال: إنّ قوله: « اذا بلغ الماء. الى آخره »(١) معارض بقولهصلىاللهعليهوآله في النبويّ المشهور: « خلق اللّه الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلاّ ما غيّر لونه. إلى آخره »(٢) لأنّ قوله : « لا ينجسه شيء » إمّا متعلّق بقوله: « خلق اللّه الماء » أو متفرّع عليه. وعلى التقديرين يجب أن تكون عدم نجاسة الماء بمجرّد الملاقاة مقتضى خلقته الأصليّة، مع أنّ الخارج من عموم « خلق اللّه » ليس إلاّ القليل.
وعنوان المخصّص اذا كان وجوديّاً اقتضى كونه مانعاً، وكون عنوان العامّ مقتضياً - كما لا يخفى - لكن يرد عليه: أنّ قولهصلىاللهعليهوآله في النبويّ: « لا ينجسه شيء » مخصّص بمفهوم قولهصلىاللهعليهوآله : « اذا بلغ الماء »(٣) فيكون التفرّع على قوله: « خلق اللّه الماء طهوراً »(٤) عدم التنجّس بالملاقاة اذا كان كرّاً.
ولمّا كان عنوان المخصّص عدم الكرّيّة - كما هو ظاهر قوله صلى اللّه عليه و آله : « اذا بلغ الماء قدر كرّ »(٥) لزمه كون الكثرة مقتضية للاعتصمام.
فحاصل معنى الحديث بعد ملاحظة التخصيص: أنّ اعتصام الماء بالكثرة مقتضى خلقته الأصليّة، بخلاف سائر المائعات، فانّه لا ينفع في اعتصامها الكثرة، مع أنّ كون القلّة أمراً وجوديّاً لا ينفع في المقام، للقطع بأنّ ماله دخل في تأثير النجاسة في الماء هو فصله العدميّ.
هذا، ولكن بقي - هنا - شيء، وهو أنّه لا مانع من الرجوع الى عموم النبويّ عند الشكّ في مقدار الكرّ، أو ما يعتبر فيه شرعاً، لأنّ العامّ طريق الى رفع إجمال المخصّص.
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب عدم نجاسة الكرّ من الماء الراكد ح ٢، ج ١، ص ١١٧.
(٢ و ٤) عوالي اللئالي: ح ٢٩ ، ج ٢ ، ص ١٥ ، مع اختلاف يسير.
(٣) وسائل الشيعة: ح ٢ ، ج ١ ، ص ١١٧.
(٥) عوالي اللئالي: ح ٣٠ ، ج ٢ ، ص ١٦.
والحاصل: أنّ النبويّ(١) وإن لم يثبت اقتضاء الاعتصام لطبع الماء يثبت عدم المانع في الشبهات الحكميّة.
وقد يقال: إنّ قولهعليهالسلام : « لا ينجسه شيء »(٢) مقدّر بالكثرة، فلا يصحّ الرجوع اليه عند الشكّ في الكثرة، لأنّه شكّ في موضوع العامّ لا فيما خرج منه.
وفيه: أنّ كون موضوع حكم العامّ - واقعاً - هو الكثرة لا يقتضي كون مصبّ العموم مقيّداً بالكثرة.
فتلخّص من ذلك: أنّ السافل لا يتقوى بالقليل العالي، نعم، يتقوّى بالعالي المعتصم.
ويمكن دعوى عدم تقوّي العالي بالسافل إن لم يتقوّ هو بالعالي بالأولويّة، فتأمّل.
وعن المعتبر(٣) : الغديران الطاهران اذا وصل بينهما بساقيةٍ صارا كالماء الواحد، فلو وضع في أحدهما نجاسة لم ينجس، ولو نقص كلّ منهما عن الكرّ اذا كان مجموعهما مع الساقية كراً فصاعداً، انتهى.
وفي المنتهى(٤) : لو وصل بين الغديرين بساقيةٍ اتّحدا، واعتبرت الكرّية فيهما مع الساقية جميعاً.
وفي القواعد(٥) : لو اتّصل الواقف بالجاري لم ينجس بالملاقاة. فإنّ مقتضى إطلاق هذه الكلمات هو الإتّحاد في جميع صور اختلاف السطوح، فضلاً عن استوائها.
ودعوى الانصراف إلى صورة تساوي السطوح مدفوعة بالمنع، خصوصاً في كلام مثل العلاّمة الذي تعرّض في التذكرة(٦) لصور المسألة.
____________________
(١) عوالي اللئالي: ح ٣٠، ج ٢، ١٦.
(٢) وسائل الشيعة: ب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد ح ٢، ج ١، ص ١١٧.
(٣) المعتبر: في أحكام الكر، ج ١، ص ٥٠.
(٤) المنتهى: في المياه وما يتعلق بها ج ١، ص ٩، س ١٩.
(٥) قواعد الاحكام: في المياه ج ١، ص ٤، س ٢٢.
(٦) التذكرة: في احكام المياه ج ١، ص ٣، س ٢٣.
ولكنّ الإنصاف: أنّ دعوى(١) خروج مثل التسنيم عن كلام المعتبر والمنتهى ليست بكلّ البعد.
وعن الموجز(٢) وشرحه(٣) : أنّ الجاري لا عن مادّة الملاقي للنجاسة: إن كان قليلاً انفعل سافله فقط، وإن كان كثيراً لم ينفعل عاليه وسافله.
والظاهر، أنّ اعتبار العلوّ والسفل في كلامهما ليس بالنسبة الى الجريان، ضرورة أنّ القليل الجاري، الذي يستوي سطحه يكون نجساً بملاقاة النجاسة، عاليه وسافله.
وبالجملة: مقتضى العبارة: تقوّي العالي والسافل كلّ بالآخر، ولكن ذكرا(٤) في مادّة الحمّام: أنّها لو لم تكن كرّاً انفعلت بنجاسة الحياض.
وهذا يقتضي عدم تقوّي السافل بالعالي في الحمّام، فهو في غيره أولى بذلك. وممّن حكى التصريح بتقوّي كل من العالي والسافل بالآخر منه هو الشهيد الثاني في الروض(٥) ، قال - على ما حكي -: وتحرير هذا المقام أنّ النصوص الدالّة على اعتبار الكثرة مثل قولهعليهالسلام : (اذا كان الماء قدر كرّ)، وكلام أكثر الأصحاب ليس فيه تقيّد الكرّ المجتمع بكون سطوحه مستوية، بل هو أعمّ منه. ومن المختلفة كيف اتّفق. وتبعه في ذلك صاحب المدارك(٦) .
نعم، خالفه في ذلك ولده في المعالم(٧) . ولم يستبعد اعتبار المساواة، قال: لأنّ ظاهر أكثر الأخبار المتضمّنة لاشتراط الكرّ والكمّية اعتبار الاجتماع في الماء، وصدق الواحد والكثير عليه، وفي تحقّق ذلك مع عدم المساواة في كثير من الصور
____________________
(١) ادّعاه السيد في المدارك: في احكام الكر، ج ١، ص ٤٤.
(٢ و ٣) الرسائل العشرة (الموجز الحاوي): في المياه ص ٣٦.
(٤) كشف الالتباس: في الجاري لا عن مادة ص ١٢، س ٢ من الصفحة الثانية.
(٥) الروض: في المياه واحكامه ص ١٣٥، س ١٦.
(٦) مدارك الاحكام: في احكام المياه ج ١، ص ٤٤.
(٧) المعالم: في عدم اعتبار استواء السطوح ص ١٢.
نظر، انتهى.
أقول: إن كان مراد صاحب المعالم: أنّه يعتبر في اعتصام الماء زيادة على كون الماء الواحد كرّاً تساوي سطوحه، واجتماعه في محلّ واحدٍ، فلا ريب أنّه خلاف ظاهر الأدلّة، فأنّها ظاهرة في إناطة الاعتصام بنفس الكرّية.
والحاصل: أنّ الهيئة، وكيفيّات الأوضاع لا ربط لها باعتصام الماء، وإن كان المقصود أنّ مع انتفاء التساوي والاجتماع تنتفي الوحدة ولا يوصف الماء بالكرّيّة، فهو - أيضاً - غير مطرد، إذ كثيراً ما يتّصف الماء بالوحدة، مع أنّه ماء منحدر.
ولذلك، ألزم صاحب المدارك(١) على القائلين بعدم تقوّي الأعلى بالأسفل بنهر عظيمٍ جارٍ في أرض منحدرة، فإنّ مقتضى ذلك تنجّس الأعلى بنفس النجاسة، وتنجّس الجزء الثاني من محلّ الملاقاة بملاقاته، وهكذا. ؛ إلاّ أن ينهي الى آخر الماء، فلولا وضوح الوحدة والتقوّي لم يكن لهذا الإلزام موقع.
وممّا يشهد على أنّ المناط هو الوحدة، ومعه لا إشكال في التقوّي، وأنّه ليس للهيئة دخل، أنّه نسب الوحيد البهبهاني(٢) الى الأصحاب عدم الإشكال في الماء الجاري على الأرض المنحدرة، لأنّه واحد عرفاً.
وردّ بذلك على صاحب المدارك(٣) ، الذي ألزم القائلين بعدم تقوّي الأعلى بالأسفل، وبأنّه مثل ذلك خارج عن محلّ كلامهم، وأنّه ليس لهم كلام ظاهر في شموله لذلك.
والعجب من بعض(٤) من التزم بما أورده صاحب المدارك، وقال: إنّ كلّ جزءٍ من أجزاء ذلك الماء لوصول ذلك الجزء الملاقي للنجس اليه ينجس، وأمّا الاتّصال به فلا يؤثّر، لأنّ هذا الاتّصال في حكم العدم.
____________________
(١) مدارك الاحكام: في احكام المياه: ج ١ ، ص ٤٥.
(٢) انظر مدارك الأحكام: ص ١٣، حاشية البهبهاني.
(٣) مدارك الاحكام: في احكام المياه ج ١، ص ٤٥.
(٤) لم نعرف قائله.
ولذلك قلنا: بعدم تقوّي الأعلى بالأسفل - اذا عرفت ما ذكرنا - فاعلم، أنّ الماء المتّصل بعضه ببعض: إمّا أن تتّحد سطوح أبعاضه وتتساوى وتعتدل، أو لا، وعلى تقدير الاختلاف، إمّا أن يكون الاختلاف على وجه التسنيم، وإمّا على وجه الانحدار، والماء على جميع هذه التقادير: إمّا متحرّك أو ساكن.
فنقول: أمّا اذا كان الماء ساكناً أبعاضه، غير جار فلا إشكال في أنّ اعتصامه لا يتوقّف على غير كرّية مجموعه، وأنّه يكون في نفسه ماءً واحداً، عقلاً وعرفاً، وأنّه لا يوجب اختلاف السطح بأيّ نحو وقع تعدّد الماء عرفاً، بحيث تختلف أبعاضه في الحكم، ولا يتقوّى بعض بمثله. واعتبار الاجتماع في محلّ واحدٍ فيه، وعدم انبساطه في جدول قليل العرض، كثير الطول - مثلاً - لا دليل عليه بعد صدق الوحدة والكرّيّة.
والظاهر، أنّ خلاف صاحب المعالم(١) ليس في هذا المقام، وعبارته وإن أوهمت اعتبار الاجتماع، ولكن يحتمل أن يكون في قبال التفريق بالجريان، الموجب لتعدّد أبعاض الماء، أو الشكّ في الوحدة دون مثل الماء الساكن، الذي لا يوجب الهيئة فيه اختلاف أبعاضه في الحكم وتعدّدها عرفاً.
وأما اذا كان جارياً - فقد عرفت - أنّ له صوراً ثلاثاً:
الاولى: أن تكون أبعاضه متساويةً في السطح، والمراد بمتساوي السطح: إمّا كون سطح الماء بحيث اذا فرض عليه خطّ مستقيم لم يخرج شىء من ذلك الخطّ عن ذلك السطح.
وإمّا أن يكون المراد: هو الاعتدال العرفي، فيكون مثل العمود القائم تكون أبعاضه متساوية السطح، وكذلك الماء البسيط على وجه الأرض، فالغديرين المتواصلين بساقيةٍ معتدل سطحها، ويخرج منه مثل النهر الجاري على أرض منحدرة، فإّن الماء فيه وإن تساوى سطحه بالمعنى المتقدّم لكن لا يقال له عرفاً: إنّ سطحه معتدل، بل
____________________
(١) المعالم: في عدم اعتبار استواء السطوح ص ١٢.
يكون بمقدار تحديره خارجاً عن حدّ الاعتدال.
ولكنّ الإنصاف: أنّ جعل مثل الماء الجاري على الأرض المنحدرة، مع فرض استواء سطحه بالمعنى المتقدّم داخلاً في محل الخلاف، في مسألة تقوّي العالي بالسافل، دون مثل العمود القائم.
ودعوى أنّه يتقوّى العالي بالسافل، في مثل العمود وبالعكس، دون مثل الماء الجاري على الأرض المنحدرة - كما مرّ - في غاية الصعوبة. فإنّ الاتحاد العرفيّ في المثالين واضح، ولا فرق بينهما في الوضوح والخفاء، حتى يكون أحدهما قابلاً للخلاف دون الآخر.
وقد عرفت ما حكيناه عن الوحيد البهبهانيّ(١) : من أنّ جعل النهر الجاري على الأرض داخلاً في محلّ الكلام مشكل، وأنّه ليس لأصحاب القول بعدم تقوّي السافل بالعالي عبارة ظاهرة في شموله لمثل ما نحن فيه.
وكيف كان، فالماء الجاري إمّا تكون سطوح أبعاضه متساويةً، ويعدّ الماء - عرفاً - معتدل السطح وإمّا أن لا يكون كذلك: فإمّا أن يكون الاختلاف على وجه التسنيم كالماء الجاري من آبارٍ، أو جدولٍ قائمٍ، وإمّا أن يكون على وجه التحديد.
أمّا اذا كان معتدل السطح فلا إشكال، ولا خلاف في أنّه تتقوى أبعاضه بعضها ببعض، وأنّه تنجس بالملاقاة جميع أجزائه اذا كان مجموعه قليلاً، إلاّ مع شدّة الجريان، أو كون الماء مثل العمود، فإنّ العالي لا يتنجّس في مثل هذا الفرض.
نعم، في تقوّي العالي بالسافل، وبالعكس في مثل الماء الجاري كالعمود إشكال سيأتي - إن شاء اللّه تعالى - كما أنّه في الحكم ببقاء فوق النجاسة على الطهارة في الماء الذي استند جريانه مع اعتدال إشكال قويّ، وخروجه عن عمومات انفعال القليل مشكل، إلاّ أن يقال: إنّ مثل هذا الفرض لا يكون داخلاً في العموم.
وبيانه: أنّ مقتضى عمومات انفعال القليل هو انفعاله بالملاقاة المقتضي للتأثير
____________________
(١) تقدم آنفاً في ص ٢٠٣.
في الماء، وفي مثل الماء الجاري لا تكون الملاقاة مقتضياً للتأثير الى فوق محلّ الملاقاة.
والحاصل: أن المستفاد من أدلّة انفعال الماء هو أنّ الملاقاة على وجهٍ تكون قابلة للتأثير اذا تحقّقت بالنسبة إلى الماء القليل كانت موجبةً لتنجّس الماء. ولذا ترى أنّ أحداً لا يتأمّل في الماء الوارد على النجاسة أنّ فوق محلّ الملاقاة لا يكون نجساً.
ودعوى أنّ ذلك للإجماع، أو دليل آخر أوجب الخروج عن مقتضى العمومات مدفوعة بأنّا نعلم: أنّ الخالي ذهنه عن الشبهات اذا عرضت عليه أدلّة انفعال القليل لم يكن يحصل منها إلاّ ما ذكرنا، ولا يشكّ في أنّ الماء الوارد لا يكون نجساً بواسطة ملاقاة أسفله للنجاسة.
وهذا بخلاف الماء الساكن، فإنّ السفل والعلوّ فيه في حكمٍ واحدٍ، ولو كان عمود من الماء الساكن لم يبلغ الكرّ نجس الماء كلّه بملاقاة النجاسة، ولو كانت الملاقاة من تحت الماء.
ويمكن أن يقال: إنّ مراتب الجريان مختلفة، فقد يكون الجريان بحيث يجعل فوق محلّ الملاقاة بمنزلة الوارد على النجاسة، وقد يكون خفيّاً لا يحكم فيه بذلك.
وهذا هو الفارق بين أقسام الجريان، بل قد يجعل شدّة الجريان الأسفل بمنزلة الأعلى- كما ستأتي الإشارة إليه-.
ومن هنا يشكل الأمر بالنسبة الى العمود القائم اذا كان مجموعه كرّاً، ولاقى النجاسة من تحت مثلاً، لإمكان أن يقال: إنّ المستفاد من أدلّة اعتصام الكرّ أن يكون ما تحقّق فيه مقتضى النجاسة كرّاً، ولا ريب في أنّه في مثل العمود الجاري لا يكون فوق محلّ الملاقاة داخلا في المورد الذي تحقّق فيه مقتضى النجاسة كما عرفت.
فلو قلنا: إنّ مثل العمود القائم داخل في متساوي السطح، وقلنا: إنّ اختلاف السطح لا ينافي الوحدة أشكل الحكم من هذه الجهة.
ولكن يمكن أن يقال: إنّ الملاقاة تقتضي نجس الملاقي والتأثير فيه، إلاّ أنّ الجريان مانع عن وصول الأثر عرفاً، لا أنّ اقتضاء الملاقاة متقيّد بعدم الجريان،
حتى لا يكون المقتضى بالنسبة الى فوق محلّ الجريان ثابتاً. وحينئذٍ نقول: المستفاد من حديث الكرّ أنّ مفروض الكرّيّة لا يتأثّر بملاقاة النجاسة، ولا تؤثّر هي فيه، فإن وجد مانع عن تأثير الملاقاة بالنسبة الى بعض أجزاء الماء كانت الكرّيّة بالنسبة الى ما ليس له مانع مانعاً عن التأثير.
وملخّص الكلام: أنّ المستفاد من الحديث(١) الدالّ على عاصميّة الكرّ هو أنّ مقتضى التنجّس أنّما يؤثّر مع اتّصاف الماء بالكرّيّة، وخلوّ المورد عن المانع غير مأخوذٍ فيه، والجريان مانع عرفي عن تأثير الملاقاة، لا أنّ المقتضى الاعتصام باستواء السطوح، والوجه في الرجوع الى العموم في الأخيرين واضح، لأنّ الشكّ في التخصيص، وكذا الوجه في الرجوع اليه مع الشكّ في المصداق اذا كان الماء مسبوقاً بالقلّة لاستصحاب عدم الكرّيّة.
وأمّا اذا لم يكن مسبوقاً بالقلّة لغرض وجوده دفعةً، أو للجهل بحالته السابقة ترادف حالتي الكرّيّة والقلة عليه فقد يتأمّل في الرجوع فيه الى العمومات، بناءً على أن العام لا يكون مرجعاً للشبهات المصداقيّة لعدم لزوم تخصيصٍ زائدٍ على علم حصوله.
إلاّ أن الأقوى فيه الرجوع الى العمومات: إمّا لأنّ أصالة عدم الكرّيّة، وإن لم تكن جاريةً لانتفاء العلم بوجودها سابقاً إلاّ أنّ أصالة عدم وجود الكرّ في هذا المكان يكفي لإثبات عدم كرّيّة هذا الموجود، بناءً على القول بالاصول المثبتة.
وإمّا لأنّ الشكّ في تحقّق مصداق المخصّص يوجب الشكّ في تحقق حكم الخاصّ لمورد الشكّ، فاذا انتفى حكم الخاصّ ولو بضميمة أصالة العدم يثبت حكم العامّ، إذ يكفي في ثبوت حكم العامّ عدم العلم بثبوت حكم الخاصّ، بخلاف حكم الخاصّ، فانّه لا يكفي في ثبوته إصالة عدم حكم العامّ، وما ذكر من أنّ المرجع في الشبهات المصداقيّة ليس الى العام إنّما يسلّم عند دوران الأمر بين المتباينين.
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد ح ٢، ج ١، ص ١١٧.
أمّا اذا كانت الشبهة من باب الأقلّ والأكثر فالمرجع إلى العموم. وأمّا لأنّ عنوان المخصّص في المقام من قبيل المانع عن الحكم، الذي اقتضاه عنوان العام فلا يجوز رفع اليد عن المقتضي، إلاّ اذا علم بالمانع، ومع الشكّ فالأصل عدم المانع، وإن كان ذات المانع - كالكرية فيما نحن فيه - غير مسبوق بالعدم.
والحاصل: أنّه فرق بين ما اذا كان العامّ عند التكلّم منقسماً بقسمين يقتضي كلّ منها حكماً مغايراً لحكم الآخر، وبين ما اذا كان عنوان المخصّص من قبيل المانع من ثبوت حكم العام(١) . إنتهى كلامه - رفع مقامه - وفيه مواقع للنظر:
قوله: لأنّ القلّة أمر عدميّ.
أقول: الماء اذا كان مقدّراً بمقدارٍ معيّن، سواء كان ذلك بالغاً حدّ الكرّ أم غير بالغٍ فذلك موجود خاصّ، وتميّزه بنفسه، وعدم الزيادة الموجبة لبلوغ الماء حدّ الكرّ ليس جزءً مقوّماً للماء.
وأمّا عروض الطهارة، أو النجاسة فيحتمل أن يكون منشؤها أمراً وجوديّاً، هو اجتماع مقدار يوجب استهلاك النجس فيه، وعدم وجود ذلك المقدار فتكون الكثرة في الكر سبباً للاعتصام، وعدمها سبباً لتأثير الملاقاة، لأنّ المانع عن تأثير الملاقاة هو التدافع المنتفي هنا.
ويحتمل أن تكون طبيعة الماء مقتضية في ذاتها للاعتصام، ولكنّ القليل الغير البالغ حدّ الكرّ تعرض عليه خصوصيّة، توجب تلك الخصوصيّة تأثير الملاقاة. فكأن تلك الخصوصيّة توجب قابلية الماء لقبول النجاسة وتأثير الملاقاة فيه، ومجرّد عمود طهوريّة الماء، وكون المستثنى أمراً عدمياً لا يدلّ على أنّ علّة انفعال القليل في الواقع، وفي نظر الشارع انتفاء الكثرة، وأنّها هي التي أوجبت اعتصام الكثير.
____________________
(١) أي كلام السيد المجدّد الشيرازي -قدسسره -.
والحاصل: إنّا إن منعنا ظهور الشرطيّة في كون الكرّ سبباً للاعتصام لا يكفي كون المستثنى عن عنوان العامّ، وهو القليل الذي ادّعى أنّه أمر عدميّ باعتبار فصله في إثبات ذلك.
قوله: لأنّ الشكّ في التخصيص.
أقول: المراد من العموم الذي يرجع اليه: إن كان مفهوم حديث اعتصام الكرّ فلا ريب أنّه تابع للمنطوق، فاذا فرض فيه إجمال عرض ذلك على المفهوم أيضاً.
وإن كان الخبرين الأخيرين ففيه - أيضاً -: أنّ ظهور المستثنى منه في العموم والخصوص تابع للاستثناء، فاذا كان في المستثنى إجمال لا يرفع عموم المستثنى منه إجمال المستثنى.
والحاصل: أنّه لا يعامل مع عموم المستثنى منه، مع إجمال المستثنى معاملة إجمال المخصّص المنفصل في العمل بالعموم، ورفع إجمال المخصّص به.
فاذا فرضنا أنّ الحوض الكبير الذي استثني من عموم الانفعال مجمل من حيث المقدار، ومن حيث الكيفية باعتبار استواء السطوح، أو غيره لم يمكن الرجوع الى عموم الانفعال، إلاّ أن يدّعى ظهور المستثنى في المقدار الذي يعلم أنّه كر، وفي الماء المستوي سطوحه، ويكون الشكّ في التخصيص المنفصل، فإنّ العموم - حينئذٍ -لاستقراره في ما عدا المستثنى يجب الأخذ به، حتى يبين المخصّص ويعلم وجوده.
لكنّه -رحمهالله - صرّح في اثناء كلامه: أنّ المرجع الى الأصل بعد فرض عدم إطلاق في الكرّ.
ويمكن أن يقال: إنّ الحوض الكبير، الذي يستقى منه - غالباً - أزيد من الكرّ، ومقتضى ظاهر الكلام: أنّ مع عدمه ينجس الماء بالملاقاة.
غاية ما في الباب: أنّه علم من الخارج أنّ مقدار الكرّ - أيضاً - معتصم، فاذا
كان مروراً بين الأقلّ والأكثر كان الأكثر هو المتيقن خروجه عن المستثنى منه، وكذلك يمكن أن يقال بالنسبة الى استواء السطح.
فيقال: إنّ الظاهر من الحوض هو المستوي السطوح، دون غيره بالبيان المتقدّم.
قوله: إذ يكفي في ثبوت حكم العامّ. الى آخره.
أقول: ظاهر التعليل ينافي ما علّل له، لأن مقتضى التمسّك بأصالة العدم هو أن ثبوت عدم الخاصّ، ولو في مرحلة الظاهر، ولو بمثل أصل البراءة يقتضي حكم العامّ، وظاهر التعليل كفاية عدم العلم.
والظاهر، أنّ مراده: هو ما دلّ عليه التعليل، ويشهد له إثباته -رحمهالله - الفرق بين محلّ البحث، وغيره، وجعل ذلك من باب تردّد المخصّص بين الأقلّ والأكثر، فانّ ذلك يقتضي أن يكون المرجع هو العموم، مع الشكّ في التخصيص، لا الرجوع الى أصالة عدم حكم الخاصّ، وإن كان هذا الفرق - أيضاً - غير مؤثّر، لما تقرّر في محلّه من أنّ الشكّ في مصداق المخصّص المبيّن المفهوم لا يرجع فيه الى العموم، سواء كان مرجع الشكّ الى الأقل والأكثر أم غيره.
قوله: وأمّا لأنّ عنوان المخصّص في المقام من قبيل المانع.
أقول: على تقدير تسليم ذلك لظهور الحديث في علّيّة الكرّيّة للاعتصام نقول: لا دليل على جواز العمل بالمقتضي، مع الشكّ في المانع، إذ لم يكن هناك أصل يوجب احراز عدم المانع كالاستصحاب مثلا، وبناء العقلاء على ذلك بمعنى: أنّه مع وجود المقتضي، والشكّ في المانع يبنى على عدم المانع عند العقلاء ممنوع اذا لم يكن مجرى استصحاب عدم ذات المانع كما هو فرض كلامه -رحمهالله -، وكذلك
بناؤهم على العمل على المقتضي، مع الشك في المانع تعبداً - أيضاً - ممنوع.
نعم، في بعض الموارد يعمل العقلاء عليه من باب الاحتياط، ولكنّ قاعدة الطهارة حاكمة على ذلك، رافعة لموضوع هذا الاحتياط، كما أنّها حاكمة على ذلك - أيضاً - اذا كان من باب الأصل في مورد الشكّ في المانع، بل تسمية ذلك حكومةً لا يخلو عن شيء، بل هو الردع عن العمل بما بنوا عليه.
وأمّا أصالة عدم المانع: إن ثبت البناء عليها فيما نحن فيه، وحجّيّتها فهي حاكمة على قاعدة الطهارة، كما يظهر ذلك بالتأمّل إن شاء اللّه تعالى.
ثم اعلم، أنّه لا وجه لتمسّك المذكور هنا بأصالة عدم المانع، دون الفرضين السابقين، فأنّ الظاهر عدم الفرق بين الشبهة المصداقيّة والشبهة الحكمية في ذلك، إلاّ أن يدّعى بناء العرف في الأوّل، لأن ملاك عدم المانع فيه بيده بخلاف الثاني، وذلك - أيضاً - مشكل.
والتحقيق: أمّا في الشبهة المصداقيّة فهو الرجوع الى الحالة السابقة، إن كثرةً وإن قلّة، وحيث لا يعلم له حالة سابقة يرجع اليها فالمرجع أصالة الطهارة السليمة عن مزاحمة أصالة اقتضاء المقتضي عند الشك في المانع كما عرفت.
وأمّا في الشبهة الحكمية. فالمرجع هو عموم قولهعليهالسلام : « خلق الماء »(١) وقولهعليهالسلام : « كلّما غلب الماء »(٢) مع فرض انتفاء الاطلاق في حديث الكرّ، ومع فرض المناقشة في العموم سنداً، أو من وجه آخر فالمرجع أصالة الطهارة أيضاً، إلاّ أن يقال: إنّ مقتضى أصالة عدم حصول المانع الواقعي، الذي جعله الشارع مانعاً، وهو عالم به، وإن كنّا لم نعلمه بخصوصه، هو البناء على تأثير المقتضى في بعض الموارد، ومقتضى أصالة بقاء المانع الشرعي في بعض الموارد هو البناء على الاعتصام.
____________________
(١) عوالي اللئالي: ح ٢٩، ج ٢، ص ١٥.
(٢) وسائل الشيعة: ب نجاسة الماء بتغيير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة ح ١، ج ١، ص ١٠٢.
نعم، حيث تكون الحالة السابقة على هذه الحالة، التي يشكّ معها في الحكم مجهولاً يكون المرجع هو أصالة الطهارة ، فيصير حال الشبهة الحكميّة كالموضوعية مثلاً اذا كان الماء مسبوقاً بمقدار يعلم أنّه كرّ شرعي، ثمّ نقص بمقدار يشك معه في أنّ الماء بالغ حدّ الكرّ العاصم، فإنّ ذات الحالة السابقة وإن كانت معلومةً انّها قبل ذلك كانت بلوغ الماء حدّاً يعلم معه وجود الكرّ الشرعي، ويعلم أنّ تلك الحالة ارتفعت قطعاً، لكن نشكّ في أنّ ذلك صار سبباً لارتفاع ما هو مانع - شرعاً - عن تأثير الملاقاة في نظر الشارع، فيجب - حينئذٍ - استصحاب بقاء ذلك المانع، وقد يكون الفرض عكس ذلك، كما اذا كان الماء أوّلاً قليلاً، ثمّ زيد عليه مقدار يشكّ معه أنّه الكرّ الشرعي، الذي جعل بالغاً مع علمنا بمقدار الماء مع الزيادة أيضاً، فيجب في استصحاب عدم حصول المانع الشرعي عن تأثير الملاقاة.
ولكنّ التمسّك بهذا الأصل عندي مشكل غاية الإشكال، ولتنقيح الكل للكلام محلّ آخر.
ويمكن أن يقال: أيضاً: إنّ مقتضى أصالة عدم جعل الشارع الكرّيّة، مع عدم استواء السطوح مثلاً، أو عدم جعله المقدار المعلوم الذي يجهل كونه عاصماً شرعاً، مانعاً عن تأثير الملاقاة هو البناء على تأثير الملاقاة عند عدم حصول مانعٍ يقينيّ، غير هذا الذي يشكّ حاله، إلاّ أن يدّعى أن ذلك من الاصول المثبتة.
وتوضيح ذلك: أنّ المقتضي للنجاسة بعد إحراز قابليّة الماء بذاته للنجاسة - بمقتضى ظاهر حديث الكرّ كما مرّ تقريره - هو الملاقاة الحاصل في محلّ الفرض بالفرض.
ومعنى مانعيّة الشيء بعد إحراز المقتضي الشرعي - الذي هو عبارة عمّا يترتّب عليه الشيء لو خلّي وطبعه - هو تأثيره في دفع أثر المقتضي الموجود، فبقاء طهارة الماء مثلاً، بل عدم نجاسته بالملاقاة من آثار حصول الكرّيّة.
وأمّا ترتّب النجاسة على الملاقاة، حيث لا مانع فهو من اللوازم العقلية لعدم جعل الشيء مانعاً.
والحاصل: أنّ معنى كون الكرّيّة مانعاً عند الشارع هو حكمه عند حصول الملاقاة معها لعدم تأثير الملاقاة، وبقاء الحالة السابقة. ومعنى عدم جعل المانعيّة على هذا عدم حكمه في الواقع ببقاء الحالة السابقة، وعدم حكمه لعدم تأثير الملاقاة. ولازم هذا المعنى - شرعاً - ليس ترتّب النجاسة على الملاقاة، بل هو لازم عقليّ لذلك، إذ لا يمكن في الواقع أن لا يحكم بالمانعيّة، ولا يحكم - أيضاً - ببقاء الحالة السابقة.
هذا ما يسر لي في توجيه ذلك، ولكنّه يحتاج الى مزيد تأمّل، ثم اذا كان الماء بحكم الاصول طاهراً فهل تترتّب عليه المطهّريّة على وجهٍ تترتب على الماء المعلوم كرّيّته واعتصامه، أو متوقف في ترتب ذلك عليه؟
وجهان: من أنّ الأحكام الخاصّة المترتّبة على الكرّ لابدّ في ترتبها من أن يتحقّق كرّ.
ومن أنّ الحكم الشرعيّ ليس لعنوان الكرّ، بل للماء الذي يبقى معتصماً ولو بأصل ظاهريّ.
والحاصل: أنّ الإجماع على أنّ كلّ ماء لا ينجس بالملاقاة، وتبقى طهارته بعدها، ولو بحكم أصل ظاهريّ فهو مترتّب عليه تلك الأحكام المترتبة على الكرّ. فإنّ منشأ اختصاص الكرّ بأحكام خاصّةٍ ليس إلاّ بقاء طهارته.
فكلّ ماء يكون حاله كحال الكرّ في أنّه تبقى طهارته يترتّب عليه تلك الأحكام. هذا، ولعلّه يأتي تتميم لهذا المطلب في بعض الكلمات الآتية إن شاء اللّه تعالى.
اعلم، أنّه اشتهر فيما بين المتأخّرين مسألة، وهي أنّه هل يعتبر في موضوع الكرّ، أو حكمه تساوي السطوح، أم لا؟ والأصل في ذلك - كما قيل - كلام العلاّمة - رحمة اللّه عليه - في التذكرة(١) ، قال فيها: لو وصل بين الغديرين بساقيةٍ اتّحدا إن اعتدل الماء، وإلاّ ففي حقّ السافل، فلو نقص الأعلى عن كرّ نجس بالملاقاة، ولو كان
____________________
(١) التذكرة: في احكام المياه ج ١، ص ٤، س ٧.
أحدهما نجساً فالأقرب بقاؤه على حكمه مع الاتصال، وانتقاله الى الطهارة مع الامتزاج. انتهى.
وظاهره - كما ترى - اتحاد السافل مع العالي حكماً، وأنّ السافل يتقوّى بالعالي وان نقص العالي عن الكرّ اذا كان المجموع كرّاً، دون العكس.
وعن الدروس(١) : لو كان الجاري لا عن مادة ولاقته النجاسة لم ينجس ما فوقها مطلقاً، ولا ما تحتها اذا كان جميعه كرّاً فصاعداً، إلاّ مع التغيّر. انتهى، فإنّ مقتضى إطلاق كلامه أنّ ما تحت النجاسة نجس إلاّ مع الكرّيّة أنّه سواء كان ما تحت النجاسة متساوياً سطحه لسطح ما فوق النجاسة، أو سافلاً لا ينجس مع كرّيّة المجموع فهذا يقتضي تقوّي السافل بالعالي.
وأمّا تقوّي العالي بالسافل فلا يظهر من المسالك. ولكن حكي عن الدروس(٢) - أيضاً - اتحاد الواقف مع الجاري المساوي له، أو العالي عليه، ولو كان كانفراده دون السافل فهذا يدلّ على أنّ العالي لا يتقوّى بالسافل.
قلت: يمكن أن يقال: إن مقتضى العبارة الاولى تقوي العالي بالسافل، فأنّ إطلاق الحكم بطهارة ما تحت النجاسة ولو فرضنا أنّ أجزاءه - أيضاً - مختلفة السطوح يقتضي تقوّي العالي بالسافل.
والحاصل: أنّ الجزء المتوسّط بين العالي والسافل اذا كان تحت النجاسة كان بمقتضى العبارة طاهراً، مع فرض كرّية المجموع، ولازم ذلك تقوي العالي بالسافل، وحينئذٍ يقع التنافي بين عبارتي الدروس، إذا عرفت أنّ مقتضى العبارة الثانية عدم تقوّي العالي بالسافل، ومقتضى إطلاق الأوّل هو التقوّي، إلاّ أن يقال: إنّ العبارة ناظرة الى الجاري من حيث الجريان، وبيان أن الجريان يوجب عدم براءة
____________________
(١) الدروس: في المياه واحكامه ص ١٥، س ٤.
(٢) الدروس: في المياه واحكامه ص ١٥، س ٦.
النجاسة الى مبدئه، وأنّه كافٍ عصمة الماء عن النجاسة.
هذا، ولكنّ الإنصاف: أنّ الالتزام بأن الجاري ولو كان متساوي السطوح لا تؤثّر النجاسة فيه بالنسبة الى الماء الذي هو فوق النجاسة، مع عدم كرّيّة المجموع في غاية الإشكال.
فلابدّ من حمل عبارة الدروس(١) على صورة اختلاف السطوح، ولا ريب في أنّه اذا كان فوق النجاسة عالياً بالنسبة الى محلّ الملاقاة فهو لا يتأثّر. وأمّا محلّ الملاقاة وما تحته فاعتصامه تابع لكرّيّة المجموع بمقتضى عبارة الشهيد. فالتنافي بين العبارتين بحاله.
إلاّ أن يقال: إنّ عدم اتحاد الواقف العالي بالجاري، الذي هو تحته لا يلازم إنكار الاتحاد في كلّ عال بالنسبة الى سافله، وحينئذٍ يشكل ما ذكرناه أوّلاً، من أنّه يستفاد من العبارتين تقوّي السافل بالعالي دون العكس مع قطع النظر عمّا ذكرناه في العبارة من أنّ مقتضى إطلاقها تقوّي العالي بالسافل، والمحكيّ عن كشف(٢) الالتباس أنّ الظاهر منه تقوّي السافل بالعالي دون العكس.
ولكن، يظهر من معتبر الدفعة في إلقاء الكرّ بناءً على ما ذكر شارح الروضة(٣) ، من أنّ الوجه فيه أن لا يختلف سطح الماء فينجس بملاقاة النجاسة. أنّ السافل لا يتقوّى بالعالي، ويستفاد ذلك من اشتراط الكرّيّة في مادّة الحمّام، لأنّ السافل ينجس بملاقاة النجاسة.
قال في القواعد(٤) : وماء الحمّام كالجاري اذا كانت له مادّة، هو كرّ فصاعداً.
وقال في الذكرى(٥) : والأظهر اشتراط الكرّيّة في المادّة حمل المطلق على المقيّد،
____________________
(١) الدروس: في المياه واحكامه ص ١٥، س ٤.
(٢) كشف الالتباس: في تقوي السافل بالعالي ص ١٣، س ١٦ من الصفحة الثانية.
(٣) الروضة البهية: في كيفيّة تطهير الماء ج ١، ص ٢٥٤.
(٤) قواعد الاحكام: في المياه ج ١ ، ص ٤ ، س ٢٠.
(٥) الذكرى: في المياه واحكام ص ٨، س ٢٩.
ثمّ قال: وعلى القول باشتراط الكرّيّة يتساوى الحمّام، وغيره بحصول الكرّيّة الدافعة للنجاسة، وعلى العدم فالأقرب اختصاص الحكم بالحمّام لعموم البلوى، وانفراده بالنصّ.
قوله: (وما كان منه كرّاً لا ينجس إلاّ أن يغيّر أحد أوصافه).
أقول: لا إشكال ولا ريب في اعتصام الكرّ عن النجاسة بالملاقاة، وإنّما الكلام في أنّ الأصل في الماء التنجّس بالملاقاة، والكرّيّة عاصمة، أو الأصل الطهارة، والقليل خارج عن مقتضى الأصل.
فنقول : ذهب بعض المحقّقين(١) الى الأوّل ، و احتجّ عليه بأنّ مقتضى النصّ و الفتوى كون الكرّيّة مانعة عن تأثير ملاقاة النجاسة في الماء، لأنّ الظاهر من الصحيح المشهور: « اذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء »(٢) هو أنّ الكرّيّة سبب لعدم النجاسة، بل الظاهر انحصار السبب فيه كما هو قضية الشرطية، ولا ريب أنّ سببيّة الكرّيّة أنّما تتم فيما اذا كان مقتضى التنجّس موجوداً، حتى يصحّ استناد العدم اليه، إذ مع عدم المقتضي يكون انتفاء المعلول مستنداً اليه ليقدمه طبعاً على وجود المانع، كما لا يخفى.
فإن قلت: إنّ المستفاد من قولهعليهالسلام : « خلق الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلاّ ما غيّر لونه »(٣) وقولهعليهالسلام في صحيحة حريز: « كلّما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ واشرب »(٤) أنّ الماء في نفسه وطبعه يقتضي الاعتصام، خرج من
____________________
(١) مدارك الاحكام: في احكام المياه ج ١ ، ص ٣٤.
(٢) وسائل الشيعة: ب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد ح ٢، ج ١، ص ١١٧.
(٣) عوالي اللئالي:ح ٢٩، ج ٢، ص ١٥.
(٤) وسائل الشيعة: ح ١، ج ١، ص ١٠٢.
عموم ذلك القليل، فصارت القلّة مانعاً عن بقاء الاعتصام.
والحاصل: أنّ المستفاد من العموم والخصوص: أنّ القلّة اقتضت في القليل التأثير بالنجاسة، وإن كان طبع الماء بمقتضى خلقته الأصليّة هو الاعتصام، وعدم الانفعال.
قلت: لا يخفى أنّه لا يجتمع المفهوم من الحديث السابق، وما يستفاد من عموم طهوريّة الماء ضرورة أنّه لا يمكن أن يكون طبع الماء مقتضياً للانفعال والاعتصام، فلابدّ من التصرّف في مقتضي أحدهما.
فنقول: بعد خروج القليل عن العموم، ودلالة حديث الكرّ على أنّ الاعتصام مستنداً الى الكرّيّة لابدّ أن يكون موضوع العموم هو الكرّ، فتكون الكرّيّة من أجزاء المقتضي لعدم الانفعال، وبقاء الطهارة الأصلية، بل الظاهر عدم الحاجة الى حديث الكرّ في إثبات مانعيّة الكرّ، لأنّ القلّة أمر عدميّ باعتبار فصلها، فيرجع الأمر الى أنّ الكثرة هي المانع عن تأثير الملاقاة، أو الموجب للاعتصام، مع أنّ عموم قولهعليهالسلام في الماء الذي تدخله الدجاجة الواطئة للعذرة، أنّه لا يجوز التوضؤ به منه: « إلاّ أن يكون كثيراً قدر كرّ من الماء »(١) .
وقولهعليهالسلام فيما شرب منه الكلب: « إلاّ أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه »(٢) أيضاً ظاهر في أنّ الانفعال مقتضى ملاقاة النجاسة، والكرّيّة تمنع عن التأثير، واذا ثبتت مانعيّة الكرّ وجب العمل بالمقتضي عند تحقّقه، حتى يثبت وجود المانع، سواء كان الشكّ في مصداق الكرّ أم في مفهومه، أم في اشتراط الاعتصام. لا أنّ المقتضي مع الجريان غير متحقّق بالنسبة الى فوق محلّ الملاقاة، مع أنّه يمكن أن يقال - بعد فرض كون الجريان من قبيل المانع - : إنّ مقتضى مفهوم الحديث أنّ الجريان غير مانع، وإن كان عرفاً مانعاً فكلّ ماءٍ جارٍ علم من الخارج بإجماعٍ،
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد ح ٤، ج ١، ص ١١٧.
(٢) وسائل الشيعة: ب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد ح ٣، ج ١، ص ١١٧.
ونحوه أنّ ملاقاة أسفله بالنجاسة لا تقتضي التأثير في الأعلى فهو، وإلاّ وجب الحكم بكون الجاري كالساكن.
ففي مثل العمود القائم اذا لاقى أسفله النجاسة يحكم بطهارة الأعلى للإجماع، وكذلك ما يلحق به، وأمّا الجريان في متساوي السطح فلا دليل على الاعتصام به، وكونه مانعاً.
والحاصل: أنّ المستفاد من حديث الكرّ انحصار المانع عن تأثير الملاقاة في الكرّية، فليس مورد يتحقّق فيه وجود المانع بالنسبة الى بعض الماء، مع عروض الكرّيّة - أعني المجموع - حتى يحتمل أن يكون الخلوّ عن المانع - أيضاً - مأخوذاً في موضوع الكرّ العاصم، فيكون وجود المانع بالنسبة الى بعض الماء مانعاً عن تأثير كرّيّة المجموع في منع الملاقاة عن التنجّس.
وأمّا اذا كان مختلف السطح، فإمّا أن يكون على وجه التسنيم وهو أيضاً - على قسمين: إمّا أن يكون بعض المختلفين كرّاً، والآخر غير كرّ، أو ليس شيء منهما بكر.
أمّا اذا لم يكن أحدهما كرّاً ففي تقوّي كلّ منهما بالآخر - كما هو المحكيّ عن ظاهر بعض كلمات العلاّمة(١) والمحقّق(٢) ، بناءً على شمول الغديرين المتواصلين لهذه الصورة، وقد عرفت الإشكال فيه، وظاهر المحكيّ عن اخرى، والمحكيّ عن صريح الشهيد الثاني(٣) ، أو عدم التقوّي مطلقاً، كما عن جميع كلمات المحقّق الثاني(٤) ، أو تقوّي الأسفل بالأعلى دون العكس، كما هو ظاهر عبارة التذكرة(٥) .
____________________
(١) قواعد الاحكام: في المياه ج ١، ص ٤، س ٢٣.
(٢) المعتبر: في احكام الكر ج ١، ص ٥٠.
(٣) مسالك الافهام: في المياه واقسامه ج ١، ص ٣ ، س ١.
(٤) جامع المقاصد: في الماء المطلق ج ١، ص ١١١ و ١١٢.
(٥) التذكرة: في احكام المياه ج ١ ، ص ٤، س ٧.
وبعض كلمات الدروس(١) ، وقد سبقت الإشارة اليها - اقوال:
حجّة القول بالتقوّي مطلقاً هو اتحاد مختلفي السطح تسنيماً، عقلاً وعرفاً.
أمّا الاتحاد العقليّ - بناءً على بطلان الجزء الذي لا يتجزأ ظاهر - فأنّ الجسم - حينئذ - متّصل واحد.
وأمّا العرفي: فلأنّا اذا راجعنا العرف والعادة نراهم لا يعدّون اختلاف السطح منشأ للتعدّد، بل في كثير من أنواع المختلفين يحكمون بالاتحاد. فإنّا نقطع بأنّ الجاري من ميزاب نازلاً شبه العمود الى الأرض لا يعدّ - مع ما كان في نفس الميزاب - مائين مختلفين، بل المجموع عند العرف ماء واحد.
وهذا يدلّ على أنّ حكم العرف والعقل في اتحاد الماء واحد، بل الحكم بالاتحاد عرفاً في بعض فروض متساوي السطحين - كالغديرين المتواصلين بخيط ضعيف - أشكل من غيره.
وقد يستدلّ لإثبات الاتّحاد بأنّ كلّ جزئين متّصلين من الماء يعدّ - عرفاً - جزءً واحداً مع الجزء الآخر، وكذلك الجزء المتّصل بأحدهما، المتّحد معه متّحد مع الآخر، لأنّ المتّحد مع الشيء عرفاً متّحد مع ذلك الشيء عرفاً.
وفيه: أنّ من يدّعي التعدّد، وينكر الاتّحاد لا يسلّم التعدّد في كلّ جزئين متصلين - مثلاً في الماء النازل من الميزاب الى الأرض، قد يحصل عند وصوله الى الأرض وجريانه عليها زاوية من إحاطة سطح الماء الجاري على الأرض، وسطح العمود النازل.
فنقول - حينئذٍ - إنّ اتّحاد الجزئين المتصلين عند الزاوية ممنوع، بل أحدهما جزء العمود، والآخر جزء الماء الجاري على الارض. فتكون الزاوية حدّاً للمائين: النازل، والجاري على الأرض.
فإن قلت: قد مرّ أنّ المختلف الشكل الساكن بعد مجموعه ماء واحد، وليس
____________________
(١) الدروس: في المياه واحكامه ص ١٥، س ٧.
اختلاف سطحه موجباً للتعدّد، وكذلك الماء الجاري، مع تساوي السطح يعدّ ماءً واحداً فلا منشأ للتعدّد في الماء الجاري المختلف السطح.
قلت: لم لا يجوز أن يكون اجتماع الوصفين - أعني الجريان، واختلاف السطح - موجباً للتعدّي عرفاً، وإن لم يكن كلّ واحدٍ بالانفراد موجباً له.
ولكن الإنصاف: أنّ الاتحاد في كثيرٍ من الفروض غير قابل للإنكار، ولكن دعوى القطع في جميع الموارد - بالاتحاد - أيضاً - مشكل. فإن ثبت إجماع على عدم الفرق وإلا أشكل الحكم.
وكيف كان، فمقتضى القاعدة في الموارد التي ثبت الاتحاد هو تقوّي كلّ من السافل، والعالي بالآخر، إلاّ أن بعض أحكام الحمّام، مثل قولهعليهالسلام : « لا بأس اذا كان له مادّة »(١) يقتضي توقّف تقوّي السافل بالعالي على كون العالي كرّاً لانصراف المادة اليه.
فاذا كان في الحمّام كذلك كان في غيره أولى، مضافاً الى أنّ المستفاد من التعليق على المادّة كون المادّة بنفسها عاصمة للماء، لا لمجموع المركب منها، ومن غيرها المتصل بها.
وذلك لا يكون مع كرّيّة المادة، إذ الماء الراكد القابل للاعتصام ليس إلاّ الكرّ، إلاّ أن يدّعى في خصوص الحمّام في المادة أنّ القليل منها أيضاً عاصمة - كالكرّ - كما هو المنسوب إلى المحقّق(٢) -رحمهالله - ولكنّه مشكل، يمكن دعوى الإجماع على خلافه.
ولقد فرغت من تسويد هذه الرسالة من نسخته الشريفة التي بخطه الشريف، في ليلة ثمان وعشرين ذي الحجة في سنة ١٣٥٣ هجري. هادي بن عباس بن محمد الطباطبائي الأصفهانيّ.
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب عدم نجاسة ماء الحمام اذا كان له مادة ح ٤، ج ١، ص ١١١.
(٢) المعتبر: في احكام الكر ج ١، ص ٤٢.
رسالة في الدماء الثلاثة - الحيض وأحكامه
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه ربّ العالمين، والصلاة على محمّد سيد المرسلين وآله الغرّ الميامين، حجج اللّه على الخلق أجمعين، ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
قولهقدسسره : « وأقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة، وكذا أقل الطهر، ولا حدّ لأكثره، وهل يشترط التوالي في الثلاثة، أم يكفي كونها في جملة العشرة ؟ الأظهر الأوّل ».
أقول: لا إشكال في أنّ أقل دم يحكم عليه بالحيضية ثلاثة، وأكثره عشرة. وهل يعتبر في الأوّل عدم تخلّل نقاء يوم بينها أم يكفي كونها في جملة العشرة ؟ المشهور هو الأوّل. وعن النهاية(١) الثاني، وعلى الثاني، فهل النقاء المتخلّل بين الدمين حيض؟ فيه إشكال، وحاصل الخلاف والإشكال هو أنّ توالي أقلّ أيّام الدم شرط في كونها حيضاً أم لا، وعلى العدم، فهل اليوم المتخلّل حيض أم لا ؟ فاندفع ما يرد على ظاهر المشهور من أنّه بناءً على كون النقاء المتخلّل حيضاً، لا يكون أقلّ أيّام الحيض إلاّ ثلاثة متوالية، فينبغي تحرير النزاع في أن الثلاثة المتفرقة حيض أم لا،
____________________
(١) النهاية: باب حكم الحائض والمستحاضة وأغسالهن، ص ٢٦، س ٤.
وان كان على الأول من أفراد الأكثر. وكيف كان فحجّة المشهور، امور:
الأوّل: أصالة عدم الحيض الحاكمة على ما يوافقها ويخالفها من الاصول الحكمية، كاستصحاب الأحكام الوضعية والتكليفية، وأصالة البراءة عنها واستصحابها، كما قرّر في محلّه. نعم إن قلنا بعدم الحكومة فالاصول متساقطة فينبغي الاحتياط.
لا يقال: ان أصل البراءة بكلا معنييه معارض باستصحاب الأحكام التكليفية فيبقى أصالة عدم الحيض سليمة.
لأنّا نقول: معنى عدم حكومة هذا الأصل معارضة بما يعارض استصحاب الأحكام التكليفية.
لا يقال: أصالة عدم الحيض معارضة بأصالة عدم الاستحاضة.
لأنّا نقول: أمّا على القول بثبوت الواسطة بين الدمين فلا إشكال في عدم المعارضة، وإن قلنا بعدم الواسطة فأصالة عدم الحيض حاكمة على أصالة عدم الاستحاضة لأنّ المستفاد من الفتاوى والنصوص: أنّ كلّ ما لم يكن حيضاً فهو استحاضة(١) ، مع أنّا لو أغمضنا عن استفادة ذلك من النصوص والفتاوى قلنا أنا نثبت أحكام الاستحاضة بأن نحكم بوجوب الصلاة بمقتضى أصالة عدم الحيض السليمة عن المعارض في خصوص الصلاة، فيجب الاغتسال مع غمس القطنة للقطع ببطلان الصلاة واقعاً بدونه، لأنّها إمّا حائض أو مستحاضة. ويجب تجديد الوضوء لكلّ صلاة مع عدم الغمس، لأنّ وضوء(٢) الواحد لا يرفع حدثها قطعاً. ولا ينبغي أن يتوهّم إمكان العكس بأن ينفى بأصالة عدم الاستحاضة وجوب الأغسال وغيرها من أحكام المستحاضة ليلزم من ذلك نفي وجوب الصلاة وغيرها،
____________________
(١) وسائل الشيعة: كتاب الطهارة: باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرّة إليها مع تجاوز العشرة من ح ٧، ج ٢ ص ٥٤٤.
(٢) كذا في النسخة الخطية، والصحيح الوضوء.
لما تقرّر في محلّه من أنّ نفي الآثار واللوازم بالاصول، لا ينفي الملزوم، بخلاف إثبات الملزوم فانّه يوجب ثبوت اللازم. كذا أفاد بعض مشايخنا أعلى اللّه مقامه وزاد إكرامه. وللنظر في بعض ما ذكر مجال.
قولهقدسسره : وإن قلنا بعدم الواسطة.
أقول: لا إشكال في أنّ أصالة عدم الحيض لا يثبت كون الدم الموجود غير حيض، إلاّ على القول بالأصل المثبت، وعليه فالأصلان متعارضان، لأنّ كلاً من أصالة عدم الحيض والاستحاضة يثبت لازمها، لأنّ مفروض الكلام دوران الأمر بين الحيض وغير النفاس والعذرة والقرحة، وعدم الواسطة بين الحيض والاستحاضة غيرها، والأصلان بالنسبة إلى إثبات اللازم متعارضان.
والحاصل: أنّا نعلم إجمالاً بأنّ الدم الموجود مردّد بين الحيض والاستحاضة، والأصل عدم كلّ واحد منهما، ومقتضى هذا العلم سقوط الأصلين، فمن أين يثبت موضوع القاعدة المذكورة ؟ فتأمّل.
ثمّ إنّ ظاهر عبارة الكتاب لا يطابق ما نقلناه عنه بالمعنى، فانّه قال: إن المستفاد من الفتاوى والنصوص أنّ كلّ دم لم يحكم عليه بأنّه حيض استحاضة، ونسبة هذه القاعدة بهذا المعنى - لو كان مسلّمة - إلى أصالة عدم الحيض كنسبة قاعدة الطهارة إلى استصحابها في أنّ جريانها بعد سقوط الاستصحاب، فيكون المرجع إليها بعد تساقط الأصلين، ولا يكون موجبة لحكومة أحدهما على الآخر.
والحاصل: أنّ اصالة عدم الحيض إن ثبت بها أنّ الدم الموجود غير حيض، فموضوع القاعدة المذكورة لا يتحقق مع جريانها، فالرجوع إليها عند سقوط هذا الأصل، وإن لم يثبت ذلك، فالقاعدة جارية، سواء كان هناك أصل أم لم يكن، وليس لها تعلّق بمجرى الأصلين ليوجب حكومة أحدهما على الآخر، فتأمّل.
قوله: بمقتضى أصالة عدم الحيض السليمة عن المعارض في خصوص الصلاة.
أقول: لا إشكال في أنّ ثبوت التكليف بالصلاة في مفروض الكلام ملازم واقعاً لحدوث الاستحاضة، كما أنّ عدم حدوث الاستحاضة ملازم لعدم التكليف بالصلاة واقعاً، والمفروض أنّ مقتضى الأصلين ثبوت التكليف وعدم الاستحاضة، فالجمع بينهما مخالف للعلم الإجمالي، وطرح أحدهما المعيّن لا موجب له.
والحاصل: أنّ مقتضى عدم الحيض الذي يجب البناء عليه للأصل، هو ثبوت التكليف بالصلاة واقعاً، ومقتضى عدم الاستحاضة الذي يجب البناء عليه للأصل هو الطهارة عن حدث الاستحاضة، ونعلم قطعاً بوقوع نقيض أحدهما، والعمل بالأصلين مخالفة عملية لهذا القطع.
وبعبارة اخرى: مقتضى الأصلين مطلوبية الصلاة بدون غسل الاستحاضة، ونقطع بفساد مثل هذه، وأنّها ليست مطلوبة واقعاً، وطرح أحدهما دون الآخر ترجيح بغير دليل.
لا يقال: مقتضى أصالة عدم الاستحاضة صحّة الصلاة بدون غسلها، والمفروض القطع بخلافه، وليس مقتضى أصالة عدم الحيض بالنسبة إلى ثبوت التكليف قطعي الخلاف، فيجب طرح أصالة عدم الاستحاضة.
لأنّا نقول: هذه مغالطة فانّ مقتضى أصالة عدم الاستحاضة ليس الصحّة الملازمة للمطلوبية الفعلية بل مقتضاها الصحّة من جهة حصول هذا الشرط المجامع لعدم التكليف من جهة فقدان شرط التكليف.
والحاصل: أنّ الذي نقطع بخلافه هو المعنى المتحصّل من الأصلين، وإلاّ فكلّ أصل بإنفراده لا قطع بمخالفة مقتضاه للواقع فتأمّل.
قولهقدسسره : فيجب الاغتسال.
أقول: لا إشكال في أنّه بعد تساقط أصالتي عدم الحيض والاستحاضة من حيث الطهارة التي هي شرط للصلاة وجوداً، لا طريق ظاهراً ولا واقعاً إلى إحراز الطهارة، وان فرضنا سلامة أصالة عدم الحيض عن المعارض من حيث التكليف، فكيف يعقل التكليف بالصلاة منجزاً، ولو كان ذلك التكليف ظاهرياً؟
والحاصل: أنّ التكليف بالصلاة المتقوّمة بالطهارة موقوف على القدرة على تحصيل الطهارة، وحصول هذا الشرط مجهول، إذ لا طريق إلى العلم به، ونفس دليل التكليف لا يثبت القدرة على الإطاعة.
وبعبارة اخرى: أصالة عدم الحيض لا يثبت كون الصلاة مع غسل الاستحاضة صلاة مع الطهارة حتى تجب بوجوب الصلاة بالاستصحاب، والعقل أيضاً أنّما يلزم بذلك بعد القطع بالتكليف بالصلاة وتوقّف القطع بالفراغ عليه، والشكّ في حصول شرط التكليف لا يجامع القطع بثبوته.
فإن قلت: لا يجوز رفع اليد عن إطلاق دليل الاستصحاب بمجرّد الشكّ.
قلت: إن كان مصداق المكلّف به مبيّناً، كان لما ذكر وجه، ولكن بعد الجهل وتردّده بين ما نعلم بأنّه لا يكلّف به وما لا يعلم كونه مصداقاً، لا حكم للإطلاق.
والحاصل: أنّه لا حكم للأطلاق بالنسبة إلى غير المقدور ولو علم كونه مصداقاً، ولا حكم له بالنسبة إلى المقدور للشكّ في الصدق فتأمّل، لئلاّ يختلط عليك الأمر، واللّه الهادي.
قوله: بخلاف الملزوم.
أقول: اللازم إذا لم يكن لزومه شرعيّاً، لا يثبت بإثبات الملزوم إلاّ إذا كان
لازماً لنفس الإثبات، ووجوب الأغسال ليس من لوازم وجوب الصلاة واقعاً ولو كانت مقدّمة لها، لأنّ وجوب المقدّمة ليس من اللوازم الشرعية لوجوب ذي المقدمة، وليس من لوازم وجوب الصلاة ظاهراً أيضاً، لأنّ مقدمية الأغسال مشكوكة.
فانقدح من جميع ما ذكرنا: أنّ مقتضى الاصل هو الاحتياط بترك محرّمات الحائض، والإتيان بواجبات المستحاضة، للعلم الإجمالي بثبوت أحد التكليفين وعدم أصل حاكم يقتضي تعيّن بعض المحتملات.
الثاني: أصالة الاشتغال فانّها لو علمت أنّ الدم لا يستمرّ ثلاثة أيّام كان اشتغال ذمّتها بالتكليف المعلّق على دخول الوقت المقتضي للتنجّز بعد حصول المعلّق عليه ثابتاً، والشكّ في ثبوت المسقط فيجب إحرازه.
وممّا ذكرنا ظهر اندفاع ما اورد في المقام من أنّه أنّما يصحّ التمسّك بأصل الشغل إذا كان بعد مضيّ الوقت وإلاّ فالأصل البراءة.
وتحقيقه أنّ التكليف معلّقاً أو منجزاً إذا ثبت، فما لم يعلم المسقط يجب الاحتياط عقلاً. وتمام الكلام في الاصول. إلاّ أن يقال: إنّ هذا - مع أنّه لا يثبت به الحيض به، ولذا لا يرتفع به وجوب قضاء الصوم، بل لابدّ فيه من أصالة البراءة أو دليل آخر - انّما يسلّم إذا كان موضوع التكليف هو مطلق المكلّف، وكان الحيض مسقطاً، ونحن لا نسلّم ذلك، بل التكليف متعلّق بالطاهر عن الحيض، وبعد تعلّق الشك لا يعلم ثبوت الخطاب منجزاً أو معلّقاً.
نعم إن ثبت الشغل بمضيّ زمان يسع الفعل كان مجرى قاعدة الشغل فتأمّل.
الثالث: عموم ما دلّ على وجوب العبادات وإباحة ما يحرم على الحائض، خرج منها من علم أنّها حائض، وهي التي استمرّ دمها الى ثلاثة أيّام.
أقول: الرجوع إليها مطلقاً انّما يصحّ إذا كان الشك في تحقّق الحيض بدون التوالي واقعاً، وكانت الشبهة مفهومية، والمقدّمتان قابلتان للمنع، أمّا الثانية فلأنّ مرجع الشك إلى أنّ طبيعة الحيض تقتضي الاستمرار الى ثلاثة أيّام أم لا، وإلاّ
فمفهوم الحيض أمر مبيّن.
والحاصل: إنّ عدم كون التوالي داخلاً في مفهوم الحيض أمر واضح، انّما الشك في أنّه من لوازمه الخارجيّة حتى يستكشف من عدم اللازم عدم الملزوم، أو أنّه لازم غالبي لا يمكن القطع بالعدم مع عدمه، وأمّا الأولى فلإمكان أن يكون شرطاً شرعياً في ترتّب أحكام الحيض عليه، ولا إشكال في أنّ المرجع بعد تحقّق الصدق العرفي إطلاق ما دلّ على حكم الحائض.
بل يمكن أن يقال: مع القطع باعتبار التوالي إذا فرض الصدق حقيقة، لا يجوز الرجوع الى أدلة اعتبار التوالي، لأنّ التزام التخصيص في أحكام الحائض لا يخلو من صعوبة، وإنّما يتصوّر شرطيّة التوالي بلحاظ تنزيل منزلة العدم، ولكنّ الأولى منع كون التوالي شرطاً شرعياً، لأنّه مخالف لظاهر أدلّة اعتباره، وأدلّة أحكام الحيض.
الرابع: الأخبار الكثيرة المستفيضة، بل المتواترة الدالّة على أنّ أقل الحيض ثلاثة(١) ، فانّ الظاهر منها الثلاثة المتوالية.
لا نقول: إنّ لفظ الثلاثة ظاهرة في المتوالية، حتى يقال: انّ نذر صيام ثلاثة أيّام لا يوجب الصيام ثلاثة متوالية، بل لمّا كان الحيض من الامور التي لها وجود إستمراري، واتّحادها وتعدّدها بالاتّصال والانقطاع، كان الظاهر من لفظ الأكثر، والأقلّ، والأقصى، والأدنى، بملاحظة ذلك أكثر زمان بقاء الدم، وأقل زمان بقائه، فالمعنى أقلّ زمان وجود الحيض الذي لا ينقص عنه ثلاثة.
فإن قلت: المراد من الحيض، هو الحالة الباقية ببقاء سيلان الدم ولو حكماً، والثلاثة بالنسبة إليها متوالية، وإن كان سيلان الدم الموجب لها متفرّقاً، بناءً على أنّ النقاء المتخلّل بين الدماء حيض، كما هو المشهور.
قلت: الظاهر من الحيض هو الدم، أو سيلانه، وحمله على الحالة الحاصلة
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب أنّ أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، ج ٢، ص ٥٥١ - ٥٥٣، انظر الباب.
مجاز، لا يصار إليه بدون صارف عن الظاهر، مع إمكان منع البناء المذكور وإن كان ضعيفاً، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.
فإن قلت: إنّ المراد من العشرة التي هي أكثر الحيض هو الأكثر بحسب البقاء(١) الحالة المانعة وإن لم يكن جميعها دماً، ولذا حكم المشهور - الحاكمون بأنّ النقاء المتخلّل حيض - بأنّ الدم في اليوم الحادي عشر من مبدأ الرؤية ليس بحيض، وإن لم يكن الدم بعد الثلاثة مستمرة.
قلت: الحكم بأن النقاء المتخلّل حيض، واليوم الحادي عشر استحاضة، انما هو لنصّ(٢) خاص، وليس ذلك لتحقّق أكثر الحيض حقيقة.
والحاصل: انّ إنكار ظهور الأخبار في التوالي يشبه المكابرة.
حجّة القول بعدم إعتبار التوالي الأصل، وقد قرّر سابقاً، وإطلاق ما دلّ على حكم الحائض بعد الصدق العرفي.
فإن قلت: إنّ الرجوع الى العرف انّما هو في تشخيص مفاهيم الألفاظ، وأمّا الشبهة المصداقية بعد تبيّن المفهوم، فالرجوع فيها الى العرف لا وجه له.
فإن قلت: المرجع فيها أيضاً هو العرف، ولذا لا يحكم بنجاسة أثر الدم الباقي بعد الغسل، ويحكم بأنّ الماء مطلق، ويترّب عليه أحكام الاطلاق مع الصدق العرفي، وإن كان الأثر بحكم العقل عيناً غير خالص.
ولكنّ الإنصاف أنّ الرجوع في الموارد التي لم يكن الحكم بالصدق منهم من باب المسامحة، بل كان لأجل الأمارات الغالبيّة، والجهل والغفلة عن التخلّف مشكل، لأنّ الرجوع إليهم في موارد المسامحة حقيقة رجوع إلى تعيين المفهوم، وأنّ المراد من اللفظ هو الطبيعة الصادقة على هذه المصاديق، أو المفهوم الحقيقي العقلي، وأمّا في مثل ما نحن فيه الذي ليس لهم فيه مسامحة، فمفهوم اللفظ والمراد منه مبيّن،
____________________
(١) كذا في النسخة، والصحيح: بقاء.
(٢) وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب الحيض ح ٢، ج ٢، ص ٥٥٥.
فالرجوع إليهم ليس إلاّ رجوعاً في تعيين المصداق ولا دليل عليه، ودعوى أنّ الأحكام الشرعية واردة على الموضوعات العرفية، لا يؤثر في مثل هذا المقام.
الحجّة الثالثة: مرسلة يونس الصريحة في أنّ الأيّام المتفرّقة بين العشرة حيض(١) . بل قولهعليهالسلام : فإن تمّ لها ثلاثة أيّام فهو من الحيض وهو أدنى الحيض(٢) ، يوهن ظهور الأخبار السابقة في التوالي:
قوله(٣) قدسسره : « وما تراه من الثلاثة إلى العشرة ممّا يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض، تجانس أو اختلف ».
أقول: ظاهر العبارة أنّ الثلاثة داخلة في الحكم بقرينة قوله: « دون الثلاثة » مضافاً إلى بعد التعرّض لطرفيها دونها، ويحتمل أن يكون خارجة، وهو بعيد. بل لا يكاد يصحّ معه العبارة كما لا يخفى على المتأمّل.
وفي قوله: « مما أمكن » إشارة الى دليل الحكم، وهو قولهم : كلّ دم تراه المرأة ممّا أمكن ، أن يكون حيضاً فهو حيض ، المعبّر عنه بقاعدة الإمكان ، والمحكي عنه في المعتبر الإستدلال بها عليه(٤) وتبعه على ذلك في المنتهى ، والظاهر منه أنّها من المسلّمات(٥) ، بل عن الخلاف(٦) ونهاية العلاّمة دعوى الإجماع عليه(٧) . وحيث انّ القاعدة ممّا شاع التمسّك بها وعمّ نفعها لزم البحث في مدلولها ودليلها فنقول:
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب التتابع في اقل الحيض من كتاب الطهارة ح ٢، ج ٢ ص ٥٥٥.
(٢) وسائل الشيعة: ب أن اقل الحيض ثلاثة ايام من كتاب الطهارة، ح ٤ ج ٢، ص ٥٥١.
(٣) من هنا موجود فقط في نسخة طهران الى ص ١٧ / ٦٢.
(٤) المعتبر: ج ١ ص ٢٠٣.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٩٨ س ٣١.
(٦) لم نعثر عليه.
(٧) نهاية الاحكام: ج ١ ص ١١٨ « وليس فيه دعوى الاجماع ».
الظاهر من الإمكان هو الإمكان المقابل للإمتناع دون الإحتمال، والمراد منه ليس الإمكان الذاتي بديهة، ولا الإمكان العرضي الملازم لوجود جميع أجزاء العلّة، إذ هو لا ينفك عن الوجوب، فالعلم به لا يجامع الشك في الحيضيّة، بل المراد هو الإمكان بملاحظة الشرائط المقدرة للحيض شرعاً. والظاهر أنّ المراد من الإمكان الشرعي هو الواقعي منه لا الإمكان بحسب ما وصل إلينا من الشرائط حتى يكون أصلاً في نفي الشرائط المشكوكة.
والحاصل أنّ المراد من القاعدة إحتمالات ثلاثة:
الأوّل: أن يراد الحكم على حيضيّة ما يحتمل الحيضيّة.
الثاني: أن يراد الحكم على حيضيّة ما يمكن الحيضيّة بمقتضى الشرائط المعلومة.
الثالث: ما يمكن الحيضيّة بمقتضى الشرائط الواقعيّة.
وحيث انّ الظاهر من الإمكان ما يقابل الإمتناع بطل الوجه الأول. وحيث انّ الظاهر هو الإمكان الواقعي بطل الوجه الثاني.
لا يقال: الظاهر من الإمكان هو العقلي الملازم للوجوب في المقام، والمفروض عدم إرادته، فيدور الأمر بين إرادة الاحتمال والإمكان الشرعي، وليس الثاني أولى، لأنّا نقول:
أوّلاً: أنّ تطرّق الإحتمال يوجب الاقتصار على الإستدلال بالقاعدة فيما يشملها بالمعنى الثاني لأنّه المتيقّن.
وثانياً: أنّ الثاني هو الظاهر، لأنّ إرادة الأوّل يوجب التصرّف في اللفظ بخلاف الثاني كما لا يخفى، مضافاً إلى أنّ الحمل على الأوّل بعد معلوميّة كون القاعدة حكماً ظاهرياً لا حكما عيّن الدم بالحيضيّة الواقعيّة - إلاّ ما خرج - يوجب لغويّة التقيّد بالإمكان فتأمّل.
إذا عرفت ذلك فاعلم إنّ الشكّ في حيضيّة الدم قد ينشأ من الشكّ في وجود شرائط الحيض فيه ككون الدم من البالغة أو من غير اليائسة أو كونه دون الثلاثة، وقد ينشأ من شرطيّة الشيء للحيض ككون التوالي معتبراً في أقلّ الحيض، وقد
ينشأ مع إجتماعه للشرائط الشرعيّة من امور خارجية لا يعتبر في الحيض وجوداً وعدماً.
أمّا القسم الأوّل فليس المرجع فيه هذه القاعدة سواء كان الشرط المشكوك وجوده مقارناً للشكّ أو متأخّراً كبلوغ الثلاثة. وقد يعبّر عن حصول مثل هذا الشرط باستقرار الإمكان، وهو لا يخلو من مسامحة لأنّ ما يحصل له الشرط المتأخّر في علم اللّه تعالى لا يمكن حيضه حين الشكّ، فالشكّ في حصوله يوجب الشكّ في الإمكان لا في استقراره، وكذلك القسم الثاني.
ودعوى: أنّ الأصل عدم اعتبار الشارع للشرط المشكوك فيكون ممكناً.
مدفوعة: بأنّ الأصل إن كان جارياً فالشكّ يرفع به، فلا محلّ للقاعدة، مع أنّ ترتّب الإمكان على عدم الاعتبار ليس أمراً شرعيّاً يثبت بالأصل.
أمّا القسم الثالث فهو المتيقّن من مورد القاعدة، ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماعات المنقولة أصالة السلامة المركوزة في جميع الأذهان، فانّ الاستحاضة مرض وفساد، وقد عبّر عنه بذلك في الأخبار كثيراً.
ودعوى: أنّ مقتضى عموم أدلّة الصفات مؤيّداً بأخبار خاصّة كإرجاع الحامل والنفساء إلى الصفات في بعض الأخبار الآتية أنّ المرجع عند الشارع في الدم المشتبه هو الصفات وأصالة السلامة على تقدير تسليم رجوع العرف إليها لا تعتنى بها بعد ثبوت الميزان الشرعي فانّ الإرجاع إليها ردع عن العمل بالأصل.
مدفوعة: بأنّ مجاري الأصل خارجة عن الشبهة عرفاً، فلا يكون من موارد أخبار الصفات حتى يكون ردعاً عن العمل بالأصل.
ثمّ إن الأصل المذكور إن صحّ التمسّك به كان جارياً في كثير من موارد الشبهة الموضوعيّة كالمبتدئة والمضطربة والمتقدّم(١) على العادة.
ولكنّ الإنصاف أنّ موارد الشبهة مختلفة، فقد يكون الشكّ بدوياً بحيث يستقرّ
____________________
(١) كذا في النسخة المخطوطة، والصحيح: والمتقدّمة.
العرف على البناء على الأصل، كما إذا تخلّف بعض أوصاف الحيض مثلاً، وقد يكون مستقرّاً كما إذا كان هناك أمارة عرفية على العدم كقرب أيّام الحيض الماضي وبعد أيّامه الآتية. والأخذ به في الأوّل غير بعيد، وأمّا الثاني الذي يتوقف العرف فيه عن الحكم والتمسّك بالأصل فالاعتماد على الأصل مشكل. ومن هنا ربما يشكل التمسّك به في القسم الأول من حيث انّ الفصل في موارد إمكان الحيض بالرجوع إلى الأصل في بعض والرجوع إلى الصفات في بعض آخر غير الموارد المنصوصة مشكل.
والحاصل أنّ التمسّك بالأصل لا يخلو عن إشكال، فالأولى هو الرجوع الى الإجماعات المنقولة المتأيّدة بموافقة المشهور، وإرسالهم للقاعدة في موارد الاستدلال إرسال المسلّمات، والقصر على المتيقّن من مدلول القاعدة، وسيأتي لذلك مزيد تنقيح في بعض المباحث الآتية ان شاء اللّه تعالى.
ثمّ إنّه قد يتخيّل أنّ أخبار الصفات واردة على القاعدة من حيث انّ الفاقد لصفة الحيض لا يمكن أن يكون حيضاً شرعاً بحكم أخبار الصفات فلا يكون داخلا في موضوع القاعدة.
وفيه : أنّ الحكم بعدم كون الدم حيضاً قد يكون لاعتبار أمر في حيضية الدم في نظر الشارع كالتوالي ثلاثة أيّام، وقد يكون لقيام أمارة كاشفة عن عدم الحيضية. و الإمكان المأخوذ في القاعدة انما هو بالنظر إلى الشرائط دون الكواشف، اعتبرت أم لم يعتبر(١) . غاية الأمر أنّ الكاشف إذا كان معتبراً كان مخصصاً موضوع للقاعدة(٢) ، أو حاكماً عليها بملاحظة رفعه للشكّ المأخوذ في موضوع القاعدة، ولا يمكن الإلتزام بشيء من الأمرين في القاعدة، وبملاحظة أخبار الصفات بعد فرض اعتبارها للزوم بقاء القاعدة على ذلك التقدير بلا مورد، أو قصرها على بعض الموارد النادره
____________________
(١) كذا في النسخة الخطية، والصحيح: لم تعتبر.
(٢) كذا في النسخة الخطية، والصحيح: موضوع القاعدة أو لموضوع القاعدة.
كما اذا لم يمكن الرجوع إلى الصفة لظلمة أو مانع آخر.
والحاصل أنّا نقطع بأنّ العاملين بالقاعدة متّفقون على عدم الرجوع الى الصفات، فإن تمّ إجماعاً لم يبق مجال للتمسّك بأخبار الصفات، وإلاّ فلا وجه للتمسّك بالقاعدة في شيء من مواردها.
وممّا ذكرنا علم أنّ معارضة التمسّك بالقاعدة في حيضيّة الدم البالغ ثلاثاً باحتمال التجاوز عن العشرة وحدوث دم أشدّ لا وجه له، مع أنّ الأصل عدم حدوث الدم بعد العشرة بناءً على أنّ الأصل في الامور التدريجيّة غير جارية.
وأمّا إن قلنا بجريانها فأصالة العدم لا يجري(١) ، وإن قلنا بأن الأصل في طرف الوجود أيضاً لا يجري، لأنّ الشكّ هنا في مقتضى البقاء، لأنّ العدم مسبوق بالوجود. وكيف كان فالأصل عدم حدوث الدم الأشدّ.
والحاصل أنّ نفس إحتمال التجاوز لا ينافي الإمكان، وإثباته بالأصل مع إمكان المناقشة فيه بما عرفت من الوجهين لا ينفع بعد أصالة عدم حدوث الدم الأشدّ.
قولهقدسسره : « وتصير المرأة ذات عادة ».
أجمع علمائنا وأكثر العامّة على أنّ العادة في الحيض انما يثبت بالمرّتين. وعن بعض العامة أنّها تثبت بالمرّة الواحدة، وهو باطل، لأنّها من العود المأخوذ فيه أوّل مرتبة التكرار، ويدلّ على ثبوتها بالمرّتين، مضافاً إلى الإجماع، رواية سماعة بن مهران قال: سألته عن الجارية أوّل ما تحيض تقعد في الشهر يومين والثلاثة، قال: فلها أن تجلس ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة، فإذا اتّفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها(٢) .
____________________
(١) كذا في النسخة الخطية، والصحيح: لا تجري.
(٢) وسائل الشيعة: ب ١٤من أبواب الحيض ح ١ ، ج ٢ ص ٥٥٩ مع اختلاف.
وقولهعليهالسلام في مرسلة يونس: فإن انقطع الدم في أقلّ من سبع أو أكثر فإنّها تغتسل ساعة ترى الطّهر وتصلّي، ولا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني، فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأول سواء حتى توالى [ عليها ] حيضتان أو ثلاثة فقد علم الآن أنّ ذلك قد صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً تعمل عليه وتدع ما سواه، وتكون سنّتها فيما تستقبل إن استحاضت قد صارت لها سنّة إلى أن تجلس أقرائها، وإنّما جعل الوقت أن توالى عليها حيضتان أو ثلاث، لقول رسول اللّهصلىاللهعليهوآله للتي تعرف أيّامها: دعي الصلاة أيّام إقرائك، فعلمنا أنّه لم يجعل القرء الواحد سنّة لها ولكن سنّ لها الاقراء، وأدناه حيضتان فصاعداً(١) الخبر.
ثمّ إنّ أقسام العادة ثلاثة:
الأوّل إن تيقّن وقتاً وعدداً، وهذه أنفع العادات، فانّها تتحيّض بالرؤية ويرجع إليها عند التجاوز.
الثاني: إن تيقّن عدداً لا وقتاً، وهذه في الرؤية كالمضطربة، وفي العدد ذات العادة يرجع إليه عند التجاوز، وعبارة المصنّف يشمل القسمين، ولكن ليس فيها دلالة على أنّ من اتفق شهراها وقتاً وعدداً يحصل لها العادة بحسب الوقت، كما أنّ رواية سماعة(٢) يشمل القسمين، ولا تدلّ على حصول العادة وقتاً، فالتمسّك بها للوقتية العددية لا وجه له.
الثالث: إن تيقّن وقتاً لا عدداً، وهذه تتحيّض بالرؤية وترجع إليها عند الإختلاط في تعيّن الوقت كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى. وفي ثبوت هذا القسم من العادة بالمرّتين إشكال، إذ قد عرفت أنّ الرواية لا تدلّ إلاّ على ثبوت العدد بهما، ومثلها المرسلة، ويحتمل اختصاصها بالقسم الأوّل، بل في ثبوت أصل هذا القسم إشكال، إلاّ أن يتمسّك بإطلاق قولهعليهالسلام في مرسلة يونس القصيرة فإذا رأت الدم
____________________
(١) وسائل الشيعة ب ٧ من أبواب الحيض ح ٢، ج ٢ ص ٥٤٦. مع اختلاف.
(٢) وسائل الشيعة: ب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من اول رؤية الدم، ح ١، ج ٢ ، ص ٥٥٩.
في أيّام حيضها تركت الصلاة(١) لشمولها لمن حصلت لها عادة عرفية وقتاً، وفي حصولها عرفاً باتّحاد الوقت مرّتين بل ثلاثاً إشكال.
ثمّ إن ظاهر الروايتين حصول العادة بتوافق شهرين متّصلين فما فوق في العدد، ولو كان عدد الأيّام في شهرين فصاعداً مختلفاً وحصلت لها مثل ذلك الإختلاف في الأشهر المتّصلة بالأشهر الاولى، كأن رأت في شهر خمساً وبعده ستّاً وبعده سبعاً ثمّ رأت في الرابع كالأوّل وهكذا، أو رأت في شهر ستّاً وبعده خمساً وبعده سبعاً ثمّ رأت في الرابع كالأوّل وهكذا، ففي صيرورة ذلك الاختلاف عادة إشكال. نعم إذا صار هذا الاختلاف عادتها عرفاً أمكن التمسّك له بقولهعليهالسلام : إذا رأت المرأة الدم(٢) الخبر فتلخص من جميع ما ذكرنا أنّ العادة شرعيّة وهي المرّتان المتّصلتان بالنسبة إلى العدد دون الوقت فلا يثبت الوقتية العددية ولا الوقتية خاصّة بالمرّتين. نعم يثبت عدد الاولى بالمرّتين، وعرفية وهي جارية في جميع الأقسام، ولكن يمكن التمسّك لثبوتها مطلقاً بالمرّتين، مضافاً إلى إطلاق معاقد بعض الإجماعات بقولهعليهالسلام في مرسلة يونس: فقد علم الآن أنّ ذلك صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً تعمل عليه وتدع ما سواه(٣) ، بتقريب أن يقال: إنّ الظاهر منها كون الشرطية في مقام بيان العادة العرفية، وإن حصل العلم من توالي الحيضتين على عدد مخصوص بكون ذلك الوقت خلقاً انّما هومن نفس التوالي وليس لكون المتوالي عليه هو العدد أو كون المتوالي هو الحيضتان مدخليّة في ذلك، بل الظاهر منه أنّ نفس التوافق مرّتين على أمر دليل على أنّ ذلك الامر وقت وخلق، خصوصاً بملاحظة قولهعليهالسلام : وإنّما جعل الوقت أن توالى عليه حيضتان(٤) الخبر، فانّ الظاهر منه أنّ كلّ من كان سنته الأخذ بالأقراء يجوز لها الأخذ بالمرّتين.
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب ما يعرف به دم الحيض من دم القرحة ح ٣، ج ٢، ص ٥٦١.
(٢) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب الحيض، ح ٣ ج ٢ ص ٥٦١.
(٣ و ٤) وسائل الشيعة: ب ثبوت عدة الحيض باستواء شهرين ح ٢، ج ٢، ص ٥٤٦.
والحاصل أنّ الظاهر من الرواية هو أنّ مناط الرجوع إلى عدد مخصوص أو وقت كذلك كون ذلك خلق وطبيعة، وأنّ ذلك يحصل بالعلم به بحصوله مرّتين متّصلتين، وهذا بالنسبة الى تعيين العادة في الوقت غير بعيد، وأما حصول العادة بالنسبة إلى الإختلاف بذلك خصوصاً إذا لم يكن مرتّباً إشكال(١) فانّ دلالة المرّتين على كونه خلقاً ولو ظنّاً لا يخلو من إشكال، والتعبد بالمرّتين في إثبات الخلق مع خلوّه عن الدلالة مطلقاً يصعب إثباتها من الرواية، فتأمّل. فإن ثبت عدم القول بالفصل بين الأقسام، وإلاّ فالاحتياط لا منفي تركه.
ثم لا يخفى أنّ اعتبار الاختلاف في الوقت كاعتباره في العدد، سواء كان ذلك بالنسبة إلى الأوّل أو الآخر أو الوسط.
ثمّ إنّ الظاهر من الشهر هو الهلالي لا الحيضي ولا الجامع بينهما، إلاّ أنّ الظاهر أنّ ذكره في الخبر مبنيّ على أنّ الغالب في النساء هو التحيّض في كلّ شهر، فلا يعتبر الشهر الهلالي في حصول العادة العددية ومثله الوقتية، إلاّ أنّ حصولها في غير الهلالي متوقّف على ثلاث حيضات، فالعمل بالعادة إنّما هو في الحيضة الرابعة. ولا يعتبر في شيء من العادتين تساوي الطهر، نعم يتوقّف حصول العادة الوقتية بغير الشهر الهلالي عليه، وذلك واضح، وربّما ينسب إلى الشهيدقدسسره في الذكرى(٢) اعتباره لذلك. وفيه إشكال، وعبارته صعب الإنقياد لكلّ من الوجهين، وتغنينا عن التعرّض لها وضوح اصل المسألة.
وهل يؤخذ بأقلّ العددين في الوقتيّة المحضة لتكرّره مرّتين أولا من حيث انّه لم تحيض للاستواء مرّتين؟ وجهان، لعلّ أقواهما الأول، بناءً على ما مرّ من أن المرّتين ميزان عرفي كشف عنه الشارع، وعلى الوجهين لا إشكال في أنّه لا يثبت العدد الناقص بحيث يرجع إليه عند الإختلاط ويقتصر عليه، ضرورة أنّ ذلك قرء واحد
____________________
(١) مشكل (خ).
(٢) الذكرى: ج ١، ص ٢٨، س ٢٨.
وليس بإقراء، والمرجع هو الثاني دون الأوّل. ولو كان الإختلاف بأقلّ من يوم واحد فعن كاشف الغطاء(١) أنّه لا يقدح في ذلك، وهو على إطلاقه مشكل، فإن صدق الاستواء في العدد في جميع فروضه مشكل، بل ممنوع.
وهل العبرة في العادة باستواء الأخذ والانقطاع ولو حصل بينهما نقاء محكوم بالحيضيّة على نهج واحد أو مع الاختلاف، أو العبرة بأيّام الدم أم بالمتّصل منهما دون المنفصل؟ وجوه، ظاهر بعض العبارات خصوصاً مع قولهم: ولو اعتادت النقاء في أثناء العادة هو الأوّل كظاهر بعض النصوص كالمرسلة السابقة(٢) فانّ الظاهر منه أنّ المدار على التوافق في انقطاع الدم رأساً، وظاهر قولهعليهالسلام : كلّما كبر سنّها نقصت أيّامها(٣) هو الثاني.
وربّما يدعى انصراف إطلاق أيّام الأقراء إلى أيّام الدم، وفيه منع، مع أنّ الظاهر منها هو الأيّام الخارجية المعهودة المعلومة وقتاً وعدداً، أو لا ريب أنّ الأخذ بأيّام الدم لا يصدق إلاّ مع الأخذ باليوم الواقع بعد أيّام النقاء المتخلّلة، ولا شبهة أنّه مع الحكم بكون ذلك حيضاً يلزم الحكم بكون الدم الحاصل في أيّام النقاء حيضاً، نعم لو ادّعي الإنصراف في الأيّام المتّصلة من أيّام الحيض الواحد أفادت الدعوى شيئاً، ولكن منعه أوضح من أن يخفى. نعم لو قلنا بأنّ النقاء المتخلّل طهر لزم الحكم بأنّ الدم الحاصل في أيّام النقاء إستحاضة فتأمّل.
والحاصل أنّ القائل بأنّ العبرة بأيام الدم إن لم يراعي الوقت بالنسبة الى آخر العدد ويجعله في غير محلّه فيطالب بدليله، وإن كان مراعياً له لزم من أخذ الوقت والعدد معاً أن يكون العبرة بالأخذ والإنقطاع، بل لو لم يكن عادة في الوقت وكان النقاء المتخلّل على نهج واحد لزم جعل العدد في غير ما يوافق يوم النقاء، مثلاً من
____________________
(١) كشف الغطاء: ص ١١٥، س ١٩.
(٢) وسائل الشيعة: ب ثبوت عدة الحيض باستواء شهرين، ح ٢، ج ٢، ص ٥٤٦.
(٣) وسائل الشيعة: ب ان اقل الحيض ثلاثة ايام واكثره عشرة ايام ح ٤، ج ٢، ص ٥٥١.
كان عادتها خمسة وكان بين الثالث والرابع نقاء يومين لم يكن لها التحيّض في اليوم الرابع من مبدأ الأيام التي جعلها(١) حيضاً لأنّ عادتها رؤية الدم في السادس والسابع من مبدأ الدم، نعم من لم يكن طهرها على نهج واحد لم يوجب الأخذ بالعدد إلحاق الزائد، إذ المفروض أنّه لا وقت لها بالنسبة الى العدد الذي يقع النقاء بينه مختلفاً لا حقيقة ولا اعتباراً كما كان لها عادة اعتبارية في الفرض السابق، فليس عليها حينئذٍ إلاّ الأخذ بالعدد، وحينئذٍ يمكن أن يقال: إنّ العادة بالنسبة الى كلّ من الوقت والعدد متّبعة، فحيث لزم من إجتماعهما التحيّض بالزيادة على المعتاد نلتزم به، وحيث لا نلتزم ذلك نأخذ بالعدد.
والحاصل أنّ المناط في حصول العادة وقتاً وعدداً انّما هو الدم دون الأخذ والانقطاع، فان لزم من اجتماعهما التحيّض بالزائد نلتزم به، والمسألة محتاجة الى تأمّل، ولم أر لها في كلامهم تنقيحاً، والأقوى في المسألة أنّ المدار على الأخذ والانقطاع لصدق أيّام الأقراء على مجموع أيّام الدم وأيّام البياض المتخلّل بينها، ولقوله: فإذا انقطع الدم في المرسلة الطويلة(٢) فانّه ظاهر في الانقطاع رأساً.
ثمّ إنّه لا فرق ظاهراً فيما يتحقّق به العادة بين ما حكم بحيضيته بالوجدان أو بالتميّز أو بقاعدة الإمكان، بل لا خلاف فيه، كما هو المحكي عن المنتهى(٣) ويدلّ عليه مضافاً إلى ذلك أنّ التميّز والإمكان أمارتان شرعيتان لكون الدم حيضاً، فيصدق على من كان لها زمانان محكومان بالحيضيّة أنّها ذات أقراء متساوية فيجب عليها التحيّض برؤية الدم في أيّامها لقولهعليهالسلام : دعي الصلاة أيّام اقرائك(٤) أو نقول: إنّ تساوي الحيضتين في الوقت أو العدد أمارة لكون ذلك
____________________
(١) كذا في النسخة المخطوطة، والصحيح : جعلتها. (٢) وسائل الشيعة: ب ثبوت عدة الحيض باستواء شهرين ووجوب رجوعها. ح ٢، ج ٢، ص ٥٤٦.
(٣) منتهى المطلب: في بيان اقسام الحيض واحكامه ج ١، ص ٩٨، س ٣١.
(٤) وسائل الشيعة: ب ثبوت عدة الحيض باستواء شهرين ووجوب رجوعها اليها ح ٢، ج ٢، ص ٥٤٦.
الوقت أو العدد من مقتضيات الطبيعة وخلقاً لها، وهذان الدمان المحكومان بالحيضيّة متساويان، فهما مثبتان لكون الوقت أو العدد الجامع بينهما خلقاً، فيجب الرجوع إليه لقولهعليهالسلام في المرسلة الطويلة: خلقاً تعمل عليه وتدع ما سواه(١) .
وما يقال: إنّ الفرع لا يزيد على الأصل الراجع إلى أنّ الظن الحاصل من العادة هنا فرع التميّز فكيف يقدم على التميّز؟
مدفوع أولاً بأنّ محل الكلام هنا في التحيّض بالرؤية ولو كان بصفات الحيض، وهذا وإن كان غير مقيّد في مستمر الدم لأنّ التحيّض بالرؤية فيها مع التميّز لا إشكال فيه إلاّ أنّه يظهر فيما إذا فرض انقطاع دم الإستحاضة والبدء منها ثمّ حدث الدم في أيّام التميّز، فانّ من لا يحكم في مثل هذا الفرض بالتحيّض بالرؤية ولو مع الصفات يوجبه بمقتضى العادة الحاصلة من التميّز، وثانياً بأنّ الظن بأن التميّز في الدمين السابقين على الدم الفاقد للتميّز أمارة لكون كلّ من الدمين السابقين حيضاً، ومن ذلك نظنّ بالخلق، ومنه نظنّ بكون الفاقد حيضاً، والظنّ الحاصل من فقد التميّز لا يعارض الظنّ الحاصل من التميّز بحيضيّة السابقين لعدم مزاحمة بينهما، ولا يعارض الظنّ الحاصل من توافق الدمين في العدد أو الوقت أنّ ذلك خلق وطبيعة لعدم مزاحمة بينهما أيضاً لإمكان تخلّف الطبيعة عن مقتضاها، فالذي يزاحم التميّز هو الظنّ الحاصل من غلبة جريان الطبيعة على مقتضاها المقتضي لحيضة هذا الدم الموجود، وذلك الظنّ أقوى من الظنّ الحاصل من عدم التميّز، ولذا قدّمه الشارع على التميّز في غير هذا المورد أيضاً فافهم فانّه لا يخلو عن دقة. والمسألة محتاجة إلى مزيد تأمّل، ولعلّه يأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى، هذا كلّه فيما يثبت به العادة.
وأمّا ما يزول به فالظاهر أنّه لا إشكال في أنّ العادة المتأخّرة مقدّمة على المتقدّمة، بل الظاهر أنّه لا خلاف فيه، ويدلّ عليه مضافاً إلى ذلك أنّ المتبادر من
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب ثبوت عدة الحيض باستواء شهرين ووجوب رجوعها اليها ح ٢، ج٢، ص ٥٤٦.
أيّام الأقراء في قولهعليهالسلام : دعي الصلاة أيّام أقرائك(١) هو أيّام الأقراء حال التكليف لا حال الخطاب، ولا ما كان ملبّساً بهذه النسبة في أحد الأزمنة، ولا ريب أنّه بعد انكشاف العادة بالمرّتين يحكم الشارع بكون الأيّام الفعلي هو العادة الثانية وإن منشأ الحكم بالرجوع الى العادة كونها طريقاً إلى كون الدم الموجود حيضاً كما يظهر ذلك بأدنى تأمّل في أخبار الباب. ولا ريب انّ العادة الماضية ليس لها طريقيّة إلى ذلك أصلاً، وعن بعض العامة زوال العادة بالاختلاف مرّة، وهو غلط، منشئه تخيّل حصول العادة به، وفي زوال العادة بتكرّر الإختلاف مرّتين أو أكثر إشكال، ولكن لا يبعد الحكم به مع حكم العرف بزوال العادة، وقد مرّ وجهه.
قولهقدسسره : « الاولى: ذات العادة تترك الصلاة والصوم ».
أقول: قد عرفت أنّ لذات العادة أقساماً ثلاثة فذات العادة الوقتية منها والوقتية العددية تتحيّض لرؤية الدم في وقت العادة بلا إشكال، وأمّا العددية المحضة ففي تحيّضها بالرؤية إشكال، وإن كان الذي يلوح من ظاهر عبارة المصنّفقدسسره أنّها تتحيّض بالرؤية ضرورة أنّ العدد لا يقتضي تعيين الزمان، وكذلك الإشكال في الأوّلين، إذا كان في غير أيّام العادة لاسيّما المتقدّم عليها، والظاهر أنّ العددية المحضة حكمها حكم المبتدئة، وأمّا المتقدّم على العادة فتتحيّض إذا لم يبعد عن مبدأ العادة بحيث ينافي صدق تعجّل الوقت وإن لم يكن الدم بصفة الحيض كالعادة ومع المنافاة كالمبتدئة ، ويحتمل إلحاقها مطلقاً بالمبتدئة كما هو ظاهر المتن والمحكي عن ظاهر المحقّق(٢) والشهيد الثانيين(٣) ، وتحيّضها مطلقاً بالرؤية كما هو
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب ثبوت عدة الحيض باستواء شهرين ووجوب رجوعها اليها ح ٢، ج ٢، ص ٥٤٦.
(٢) جامع المقاصد: في الحيض وغسله ج ١، ص ٢٩١.
(٣) مسالك الافهام: في الحيض ج ١، ص ٩، س ١٩.
المحكي عن جماعة(١) .
لنا: موثقة سماعة عن المرأة ترى الدم قبل وقتها قالعليهالسلام : إذا رأت الدم فلتدع الصلاة فإنّه ربما يعجل بها الوقت(٢) فإنّ إطلاق السؤال وإن اقتضى العموم إلاّ أنّ التعليل يخصّصه.
ودعوى أنّ مقتضاه العموم أيضاً لأنّه راجع الى التعليل بالإحتمال، بل مقتضاه وجوب التحيّض عند كلّ دم محتمل الحيضيّة.
مدفوعة بأنّ الظاهر منه أنّه لرفع الاستبعاد، وأنّ التقدّم على العادة الذي صار منشأ لتخيّل السائل عدم كون الدم حيضاً لا يكون مانعاً لذلك، فحاصله أنّ الشبهة من حيث التقدّم لا يعتنى بها لكثرة وقوع تعجيل الوقت، ولا ريب أنّ عدم الاعتناء لهذه العلّة يقتضي احتمال التعجيل في الوقت، مع أنّه لو اريد التعليل بالاحتمال أيضاً كان مقتضاه التحيّض عند إحتمال التعجيل دون مطلق الاحتمال، إلاّ أن يقال: ان لا خصوصية للتعجيل، فتأمّل.
ودعوى إنصراف الدم إلى ذي الصفة مدفوعة مضافاً إلى منعه بالأخبار المستفيضة(٣) الدالّة على أنّ الصفرة قبل الحيض مطلقاً أو بيومين من الحيض أنّ مقتضى إطلاق قبل الحيض في بعض هذه المستفيضة التحيّض بالرؤية هو التحيّض مطلقاً وإن لم يكن تعجيل الوقت محتملاً، كما أنّه يمكن أن يقال إنّها في بيان حكم الدم المتقدّم على العادة بعد تحقّقها، فلا تعرّض فيها لحكم الدم قبل استقرار الإمكان، وتقريبه أنّ الظاهر من قوله: من الحيض، هو الواقعي منه، والمراد من قوله: قبل الحيض إمّا قبل الحيض المعهود الذي تراه في العادة، أو قبل أيّام الحيض، ويكون اعتبار التقدّم على الأيّام بملاحظة نفس الحيض، كما أنّ اعتبار
____________________
(١) النهاية: باب حكم الحائض والمستحاضة والنفساء واغسالهن ص ٢٤.
(٢) وسائل الشيعة: ب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم ح ١، ج ٢ ، ص ٥٥٦.
(٣) وسائل الشيعة: ب أن الصفرة والكدرة في ايام الحيض حيض ج ٢، ص ٥٤٠ و ٥٤١، انظر الباب.
التأخّر عن الأيّام بيومين بملاحظة التأخّر عن نفس الدم قطعاً، فيكون محصل المعنى أنّ الدم المتّصل بما تراه المعتاد في الوقت إن كان متقدّماً عليه بيومين حيض واقعاً، وإن كان متأخراً عنه بيومين ليس من الحيض، ومقتضى ذلك توقّف الحكم بحيضيّة الدم المتقدّم على الأيّام على إستمرار الدم إليها، إذ بدونها لا يصدق الإتّصال المذكور، وفي كلا الوجهين نظر.
أمّا في دعوى الإطلاق أنّ الظاهر من قبل الحيض هو القريب منه الذي لا ينافي صدق التعجيل، كما أنّ التحديد باليومين تقريب، ويشهد به تحديد تأخّر الدم بذلك، فأنّ الظاهر أنّ ذلك لإخراج أيّام الإستظهار، وسيأتي إن شاء اللّه أنّها إلى العشرة. وأمّا في الثاني فلأنّ الظاهر من السؤال في بعض هذه الأخبار هو السؤال عن حكم الدم فعلاً، وهو ينافي إرادة الحكم بالحيضيّة الواقعيّة من غير نظر إلى حكم حال الإبتلاء كما لا يخفى، وأمّا المتأخّر عن العادة فإن كان عن بعضها فلا إشكال في وجوب التحيّض معه لصدق كون الدم في أيّام الأقراء، وكذا المتأخّر عنها بتمامها، والظاهر أنّه لا خلاف فيه، ويدلّ عليه مضافاً إلى ذلك وإلى أنّه يحتمل أن يراد من إحتمال التعجيل في الموثقة إحتمال تخلّف الدم الأولوية بالنسبة إلى المتقدّم وأخبار العادة، فانّ الرجوع إلى العادة إذا كان الدم في أيّامها إن كان لأجل كون ذلك خلقاً مفيداً للظنّ بكون ذلك حيضاً كما هو ظاهر المرسلة الطويلة(١) يقتضي اعتبار الظنّ الحاصل من ذلك بكون المتأخّر حيضاً، ويمكن إرجاع تعليل الحكم بأنّ التأخّر يزيده إنبعاثاً إلى أحد هذين الوجهين. ويؤيّد ذلك أنّا لا نظنّ أنّ أهل الإبتلاء بهذا الدم يحصل لهن الشكّ في حيضيّة مثل هذا الدم المتأخّر، بل يمكن دعوى السيرة القطعية منهنّ على ذلك.
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب ثبوت عدة الحيض باستواء شهرين ووجوب رجوعها اليها. ح ٢، ج ٢، ص ٥٤٦.
قولهقدسسره : « وفي المبتدئة تردّد، الأظهر أنّها تحتاط ».
أقول: قال في المدارك(١) : موضع الخلاف ما إذا كان الدم المرئي بصفة الحيض كما صرّح به العلاّمة في المختلف(٢) وهذا كما ترى خلاف ظاهر المتن، بل كاد يكون خلاف صريحه، إذ الكلام بعد حكم ذات العادة التي لا فرق فيها بين الجامع للصفة وغيرها إجماعاً نصاً وفتوىً يناوي بأنّ محلّ الكلام فيهما واحد، وعبارة المعتبر(٣) كما سياتي صريحة في ذلك أيضاً، وكذلك حكي التصريح بعموم النزاع عن السرائر(٤) والشهيد(٥) .
والحاصل أنّ في المسألة أقوالا، ثالثها التفصيل بين الجامع للصفة فتتحيض برؤيته وغير الجامع فتحتاط عند رؤيته إلى الثلاثة، والظاهر أنّ الفرق بين الأفعال والتروك المحكي عن الشهيد(٦) يرجع إلى ذلك، ولكن لا يحضرني كلامه، ولعلّ الأقوى هو التحيّض بالرؤية مطلقاً، وهو المشهور كما عن الرياض(٧) أو أشهرها كما قيل، وبعده التفصيل المنسوب إلى ظاهر المقنعة(٨) ، وهو صريح المدارك(٩) وبعض من تأخّر عنه،(١٠) والقول الثاني خيرة المصنّف هنا وعن العلامة(١١) في بعض كتبه.
____________________
(١) مدارك الاحكام: في احكام الحيض ج ١، ص ٣٢٨.
(٢) المختلف: في غسل الحيض واحكامه ج ١، ص ٣٧، س ٣٧.
(٣) المعتبر: في غسل الحيض والنظر في احكامه ج ٢، ص ٢١٣.
(٤) السرائر: في احكام الدماء الثلاثة ج ١، ص ١٤٧.
(٥) و (٦) البيان: في احكام الحائض ص ٢٠، س ١٤.
(٧) الرياض: كتاب الطهارة ج ١، ص ٤٢، س ٤.
(٨) المقنعة: باب حكم الحيض والاستحاضة و. ص ٥٥.
(٩) مدارك الاحكام: في احكام الحيض، ج ١، ص ٣٢٩.
(١٠) الذخيرة: في الحيض ص ٦٤، س ٣٧، والحدائق: في مبدأ تحيض المبتدأه، ج ٣، ص ١٨٧.
(١١) التذكرة: في احكام الحيض ج ١، ص ٢٨ و ٢٩، س ١.
ثمّ إنّ عمدة ما يتمسّك به المفصّلون امور: منها عمومات أخبار الصفات، منها صحيحة البختري أو حسنته قال: دخلت على أبي عبد اللّه إمرأة سألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري أحيض هو أم غيره؟ فقال: إنّ دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة، ودم الإستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة. قال: فخرجت وهي تقول: واللّه إنّه لو كان امرأة ما زاد على هذا(١) .
وفي صحيحة معاوية بن عمار قال: إنّ دم الإستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد، إنّ دم الاستحاضة بارد وإنّ دم الحيض حار(٢) .
وصحيحة أو موثقة إسحاق بن جرير قال: سأت امرأة من أن ادخلها على أبي عبد اللّهعليهالسلام ، واستأذنت لها فاذن لها فدخلت ومعها مولدة لها، إلى أن قال: قالت: فانّ الدم يستمر بها شهراً أو شهرين أو ثلاثة كيف تصنع بالصلاة ؟ قال: تجلس أيّام حيضها ثمّ تغتسل لكلّ صلاتين، قالت: إنّ أيّام حيضها تختلف عليها وكان يتقدّم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخّر مثل ذلك فما عملها ؟ قال: دم الحيض ليس به خفاء، هو دم حار تجد له حرقة، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد، قال: فالتفت إلى مولاتها وقالت: أتراه كان امرأة مرّة(٣) .
وعن السرائر أنه رواه عن كتاب محمد بن علي بن محبوب، إلا أنه: أترنيه كان إمرأة(٤) دلّت الأخبار الشريفة على أنّ هذه الصفات معرّفات تدور الحيض معها وجوداً وعدماً.
واجيب عن ذلك مرّة بأنّ هذه الصفات أغلبية وبأنّ الدلالة على ذلك إن
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة ح ٢، ج ٢، ص ٥٣٧.
(٢) وسائل الشيعة: ب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة ح ١، ج ٢، ص ٥٣٧.
(٣) وسائل الشيعة: ب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة ح ٣، ج ٢، ص ٥٣٧.
(٤) مستطرفات السرائر: ح ٤٨، ص ١٠٥ ، ١٠٦.
كان من قولهعليهالسلام : فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواء فلتدع الصلاة(١) ففيه أنّه لا موجب فيها لعموم الحكم بغير مستمرة الدم، إذ الضمير راجع إلى مورد السؤال، وهو مستمرة الدم، وإن كان من سوق ذكر الصفات مساق ذكر القاعدة فلا يدلّ ذلك إلاّ على الوجود عند الوجود دون الانتفاء عند الانتفاء، فلا وجه للتفصيل، وان كان من قولهعليهالسلام : دم الإستحاضة كذا(٢) ، والإستحاضة دم يحدث بعد دم الحيض كما صرّح به بعض أئمّة اللغة، بل عن الوسيلة(٣) أنّه عرّفه بذلك.
ويرد على الأول أنّ ذلك لا ينافي كونها أمارات ظنّية اعتبرت لتميّز المشتبه، وعلى الثاني أنّ الشرطية وإن لم يدلّ بمفهومها على ذلك إلاّ أنّ تفريعها على الكليّة السابقة تدلّ على أنّ تلك الكليّة ميزان لتميّز الحيض، وأمّا قوله: إنّ ذلك لا يدلّ إلاّ على الوجود عند الوجود، ففيه أنّ قولهعليهالسلام : دم الحيض حار(٤) إن اخذ محموله أعمّ من موضوعه فلا يدلّ على الوجود عند الوجود وذلك يلزمه الانتفاء عند الانتفاء، إذ الظاهر أنّ القضيّة إمّا الطبيعة أو كليّة تنزيلاً للنادر منزلة المعدوم، وإن اخذ مساوياً كما هو الدين بمقام التعريف لزمن الانتفاء عند الانتفاء أيضاً.
لا يقال: إنّ لازم القضيّة وإن كان الانتفاء عند الانتفاء إلاّ أنّ المقصود منها جهة الوجود عند الوجود دون غيره، وكثيراً ما يذكر ماله مفهوم من الجمل الإستثنائية والشرطيّة وغيرها، والمقصود باللسان هو المنطوق من غير نطر إلى المفهوم. لأنّا نقول: إنّ قولهعليهالسلام : دم الحيض ليس به خفاء(٥) ظاهر في أنّ تمام المقصود في ذلك تميّز الحيض وجوداً وعدماً فتأمّل.
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة ح ٢، ج ٢، ص ٥٣٧.
(٢) وسائل الشيعة: ب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة ح ٣، ج ٢، ص ٥٣٧.
(٣) الوسيلة: في احكام المستحاضة ص ٥٩.
(٤) وسائل الشيعة: ب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة ح ٢، ج ٢، ص ٥٣٧.
(٥) وسائل الشيعة: ب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة ح ٣، ج ٢، ص ٥٣٨.
وأمّا أنّ الاستحاضة ظاهرة في المستمرّة فممنوع، والتفسير والتعريف لعلّهما بملاحظة غلبية كونه بعد الحيض، خصوصاً بعد كون مقتضى الطبيعة هذا الدم حدوثه بعد دم الحيض، فالاولى في الجواب مضافاً إلى أنّ المشهور بل الجميع لم يعملوا بها في هذه المسألة فإنّها تنافي الإطلاق في الحكم بالتحيّض، وفي الحكم بعدمه والقول بالتفصيل لم يعرف ممّن تقدّم على صاحب المدارك(١) عدا ما مرّ من ظاهر المقنعة(٢) وإلى أنّها تنافي قاعدة الإمكان التي إدعى الشيخ(٣) والمصنّف في المعتبر(٤) والعلاّمة في المنتهى(٥) الإجماع على المتيقّن من موردها، وهو الثلاثة إلى العشرة، وقد سبق عن النهاية(٦) دعوى الإجماع على أصل القاعدة أن المرجع إلى الصفات كما هو واضح انّما هو عند الاشتباه ومورد الكلام وأغلب موارد قاعدة الإمكان لا شبهة في حيضتها عند العرف.
وتوضيح ذلك: أنّه لمّا كان دم الحيض واقعاً وعند العرف من مقتضيات طبيعة النساء، ودم الإستحاضة كان لأجل فساد ومرض حتى عبّر عن ذلك الدم كثيراً بالفساد، كان الأوّل أصلاً في دم النساء دون الثاني بمقتضى أصالة السلامة المرتكز في أذهان أهل العرف، وليس عند العرف - ما لم يتحقّق إختلاط دم الحيض بدم الاستحاضة أو أمر آخر يغلب معه عدم الحيض كالحمل مثلاً - شبهة في أنّ الدم الخارج عن المرأة حيض، ولا يجعلون فقد السواد وغيره من أمارات الحيض أمارة على عدمه، بل يحتمل عدمها على حدوث اختلاف في الطبيعة من برودة أو رطوبة أوجب ذلك ولا يقفون بذلك عن الحكم بالحيضية. والحاصل أنّ أغلبية الصفات في
____________________
(١) مدارك الاحكام: في احكام الحيض ج ١، ص ٣٢٨ و ٣٢٩.
(٢) المقنعة: باب حكم الحيض والاستحاضة ص ٥٥.
(٣) الخلاف: في وجوب الاغسال على المستحاضة مسألة ٧ ج ١، ص ٦٦.
(٤) المعتبر: في الحيض واحكامه ج ١، ص ٢٠٣.
(٥) منتهى المطلب: في احكام الحيض واوقاته ج ١، ص ٩٨، س ٣١.
(٦) نهاية الاحكام: في مدّة الحيض ووقته ج ١، ص ١١٧ و ١١٨.
الحيض ليس عندهم منشأ للوقوف عن الحكم بحيضة فاقد الصفات أو للحكم بأنّه استحاضة، بل يحكمون بمقتضى قوله تعالى (فاعتزلوا النساء في المحيض)(١) على وجوب الاعتزال عمّن رأت الدم الفاسد، ولعلّ هذا الأصل هو مدرك لقاعدة الإمكان التي قد عرفت دعوى الإجماع عليها من جماعة من الأعاظم(٢) وبنى عليها العلماء حتى لم يعرف الخلاف من أحد منهم في ذلك إلاّ من جملة من متأخّري المتأخّرين(٣) .
والحاصل أنّ المبتدئة والمضطربة ومن تلحق بهما خارجة عن مورد أخبار الصفات.
فإن قلت: إن أردت أنّ العرف بملاحظة هذا الأصل قاطعون بمجرد الرؤية بأنّ الدم حيض، ففيه مع أنّه(٤) جزاف، لا يسمع أنّ مورد الكلام في وجوب التحيّض بالرؤية هو صورة الشك. وإن أردت أنّ أصل السلامة مرجع في الشكّ عند العرف، ففيه أنّه لا يجوز بناء حكم الشرع عليه إلاّ إذا قام الدليل على اعتباره. وإن أردت إستكشاف الحجيّة من قاعدة الإمكان بملاحظة أنّ مناطها ليس إلاّ هذا الأصل، ففيه أنّ حجّيته في مورد لا يلازم الحجية في محلّ الكلام، ولولا الإجماع على تلك القاعدة لم يعمل بهذا الأصل في موردها أيضاً، فالمرجع بعد قوة دلالة أخبار الصفات وسندها هو تلك الأخبار.
قلت: إستقرار بناء العرف على العمل بهذا الأصل حتى صار عندهم بمنزلة العلم والغي احتمال خلافه، وعدّ مورده بمنزلة غير المشتبه حتى لم يكن ما دلّ على الرجوع إلى الصفات رادعاً، مؤيّداً بإمكان دعوى القطع بأنّ مناط قاعدة الإمكان
____________________
(١) البقرة: ٢٢٢.
(٢) المعتبر: في الحيض واحكامه ج ١، ص ٢٠٣، ومنتهى المطلب: في احكام الحيض واوقاته ج ١، ص ٩٨، س ٣١، ونهاية الاحكام: في مدة الحيض ووقته ج ١، ص ١١٨.
(٣) جامع المقاصد: في الحيض وغسله ج ١، ص ٢٨٨، ومدارك الاحكام: في الحيض ج ١، ص ٣٢٤.
(٤) مع أنّ هذا (نسخة).
ليس إلاّ هذا الأصل، وأنّه ليس القاعدة مأخوذة من الأئمةعليهمالسلام بلفظها، يشرف الفقيه على القطع برضا الشارع بالعمل بهذا الأصل، خصوصاً بعد إستقلال العقل وإجماع العقلاء على قبح العمل بغير العلم.
وملخص الكلام أنّ العقلاء الأذكياء لا تراهم يتوقّفون بمجرد احتمال أن لا يبلغ الدم المرئي إلى ثلاثة يقفون عن الحكم بالحيضيّة ويرجعون إلى طلب إمارة اخرى غير الأصل من الصفات وغيرها، وليس في المقام ما يوجب الردع إلاّ أخبار الصفات التي هي صريحة في أنّ هذه الصفات أمارات عرفية، خصوصاً مع قول المرأة: أترنيه كان امرأة(١) ومع هذا لا يرجع إلى تلك الصفات ويؤخذ بذلك الأصل فكيف يصير مثل هذه الأخبار ردعاً ؟ وهذا يكفي في حجيّة الأصل المذكور مع تأيّده بعمل المشهور على طبقه في هذه المسألة، وإطباقهم على ذلك في مجاري قاعدة الإمكان مع قوّة الظنّ بأنّ مناط تلك القاعدة ليس إلاّ هذا الأصل، خصوصاً مع ما في كثير من الأخبار من الإشارة الى ذلك.
نعم فيما إذا حصل موهن عرفي للأصل كأمارة يوجب الظنّ على خلافه يشكل التمسّك بالأصل.
اللهم إلاّ أن يقال: إنّ الأصل إذا فرض اعتباره وطرحه بأمارة لم يثبت حجيّتها لا وجه له فتأمّل، خصوصاً مع إمكان دعوى عدم القول بالفصل.
وفيه منع، ألا ترى أنّ الشهيدقدسسره (٢) أفتى في المضطربة بالرجوع الى ظنّها، وممّا استدل به على التفصيل رواية إسحاق بن عمار الواردة في الحبلى ترى الدم اليوم واليومين، فقال: إن كان دماً عبيطاً فلا تصلّي ذينك اليومين، وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين(٣) . بناءً على عدم القول بالفصل بين
____________________
(١) مستطرفات السرائر: ح ٤٨، ص ١٠٥ و ١٠٦.
(٢) البيان: في احكام المضطربة ص ١٧، س ١٣.
(٣) وسائل الشيعة: ب جواز اجتماع الحيض مع الحمل ح ٦، ج ٢، ص ٥٧٨.
الحامل وغيرها.
وفيه: أولاً: بإمكان منع المبنى، كيف والمحكي عن ظاهر الفقيه(١) أنّ غير المتّصف لا يحكم بحيضيته ولو اجتمع فيه شرائط الإمكان.
وثانياً: بأنّ ظاهر العنوان هو استفهام حكم المرأة بعد رؤية الدم اليوم واليومين.
وظاهر الجواب هو بيان حكمها في اليومين، وحينئذٍ ممكن أن يكون المراد من الجواب أنّ حكمها الواقعي في اليومين هو ترك الصلاة فيهما، ولا ينافي ذلك عدم وجوب التحيّض بالرؤية وتوقّفه على تحقّق شروط الإمكان، فتكون الرواية حينئذٍ دليلاً على ما حكي عن ظاهر الفقيه، وأمّا كون مورد السؤال أقلّ من الثلاثة فلا ينافي ذلك، لإمكان أن يكون المراد عدداً قليلاً، ولكنّ الإنصاف أنّ هذا المعنى خلاف ظاهر الرواية.
ومنها: صحيحة ابن الحجّاج عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوماً أو أكثر ثمّ طهرت ثمّ رأت دماً أو صفرة، قال: إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصلّ ولا تمسك عن الصلاة(٢) واحتياج السؤال الى التأويل لا ينافي في التمسّك بها في المقصود.
والجواب أنّ الاستدلال بها مبني على عدم القول بالفصل بين المسبوقة بالنفاس وغيره فتأمّل.
ومنها: ما دلّ على أنّ الصفرة في غير أيّام الحيض ليس بحيض كصحيحة ابن مسلم عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها، قال: لا تصلّي، وإن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلّت(٣) . بناءً على عدم الفرق بين ما تراه المعتادة قبل عادتها ممّا لا يلحق بها وبين المبتدئة.
____________________
(١) من لا يحضره الفقيه: باب غسل الحيض والنفاس ح ١٩٧ ، ج ١، ص ٩١ و ٩٢.
(٢) تهذيب الاحكام: في حكم الحيض والاستحاضة والنفاس ح ٧٥ ، ج ١، ص ١٧٦.
(٣) وسائل الشيعة: باب ان الصفرة والكدرة في ايام الحيض حيض ح ١، ج ٢، ص ٥٤٠.
والجواب مضافاً إلى إمكان منع المعنى وإن كان ضعيفاً، أنّ الرواية مخصصة بأيّام الاستظهار بناءً على ما سيأتي، وبأيّام إمكان الحيض من الثلاثة إلى العشرة لما مرّ من الإجماعات على أنّ الثلاثة إلى العشرة حيض ومع هذا يضعف دلالتها على محلّ البحث فيمكن حملها بمعونة ما مرّ من الأصل على أيّام امتناع الحيض، هذا ومن التأمّل في بعض ما ذكرنا ظهر لك وجه القول بوجوب التحيّض بالرؤية مطلقاً.
وربما يستدلّ لذلك أيضاً بأخبار الصفات بناءً على عدم القول بالفرق بين ذي الصفة وغيره بأخبار الصفات، وفيه أنّه معارض بالقلب، بل مقتضى صحيحة ابن مسلم(١) المتقدّمة هو عدم التحيّض بالرؤية مطلقاً بناءً على عدم الفرق، إذ ليس فيها حكم لذي الصفة حتى يعارض بالقلب.
واستدلّ أيضاً بإطلاق ما دلّ على أنّ القائمة تترك الصلاة بمجرد الرؤية، وما دلّ على حكم من عجّل عليها الدم، وما دلّ على أنّ المبتدئة تصبر الى عشرة، وصحيحة ابن المغيرة في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوماً ثمّ طهرت ثمّ رأت الدم بعد ذلك؟ قال: تدع الصلاة لأنّ أيّامها أيّام الطهر [ و ] قد جازت مع أيّام النفاس(٢) . وبقاعدة الإمكان.
وفي الجميع نظر بأنّ هذه الأخبار بين ما لا إطلاق فيها هنا غير هذا الحكم وبين ما هو معارض بما يقيّده كصحيحة ابن المغيرة، وأمّا قاعدة الإمكان فقد عرفت أنّ المتيقّن من مدلولها هو ما بلغ الثلاثة.
وربما يصحّح التمسّك بالقاعدة بأصالة بقاء الدم إلى الثلاثة.
وفيه: أولاً(٣) : منع صحّة الإستصحاب إمّا لأنّه لا يجري في التدريجيات
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب ان الصفرة والكدرة في ايام الحيض حيض ح ١، ج ٢، ص ٥٤٠.
(٢) الكافي: باب النفساء تطهر ثم ترى الدم ح ١، ج ٣، ص ١٠٠. وفيه جازت أيّام النفاس.
(٣) لا يوجد الردّ الثاني في النسخة التي بأيدينا.
خصوصاً مع كون الشكّ في اقتضاء المقتضي، وإمّا لأنّه من الاصول المثبتة لأنّ ترتّب الإمكان على وجود الشرائط عقلي.
ودعوى أنّ موضوع القاعدة مصاديق الممكن وليس لعنوان الإمكان(١) مدخلية في ذلك.
مدفوعة أولاً بأنّ مقتضى ظاهر القاعدة مدخلية الإمكان، ولو شكّ في ذلك كفى في منع الاستصحاب إلاّ أن يقال: إنّ مناط القاعدة أصالة السلامة ودعم الدليل على اعتبارها في غير مورد الإمكان لا يصير سبباً لكون عنوان الإمكان مناط القاعدة.
وثانياً بأنّ الأمر على هذا التقدير سواء، فانّ الإستصحاب لا يثبت نفس الواقع وانّما هو مفيد لتنزيل المجهول منزلة الواقع.
والحاصل أنّ المراد من قولهم: « كلّ ما أمكن » إمّا الممكن لعنوانه أو المصاديق الواقعية للممكن أو معلوم الإمكان، فعلى الأوّل لا يفيد الأصل لأنّه مثبت، وعلى الآخرين لا معنى للأصل.
أمّا على الوجه الأخير فظاهر لأنّ الأصل لا يحصل به العلم، إلاّ أن يقال: إنّ العلم إذا اخذ جزء الموضوع لكونه طريقاً يقوم الأمارات مقامه فتأمّل.
وأمّا على الثاني فلأنّ الأصل ليس سبباً للبقاء حقيقة، والمفروض أنّ الإجماع واقع على حيضيّة تلك المصاديق الواقعية بما في مصاديق واقعية.
حجّة القائل بوجوب الاحتياط أصالة عدم الحيض السليمة عن المعارض وبأنّ اليقين بالشغل.
والجواب أنّ الأصل واليقين منتقضان بما مرّ من الأدلّة.
وقد يجاب عن ذلك بأنّ مدار الحكم في الثلاثة إن كان على الإحتمال فهو هنا موجود، وإحتمال عدم بلوغ الدم الى الثلاثة معارض باحتمال عبور بأبلغ ثلاثاً
____________________
(١) الممكن (نسخة).
عن العشرة مع حدوث دم أشبه بالحيض من الموجود في الثلاثة.
والحاصل أن مقتضى الحكم بالحيضية في الثلاثة موجود في المبتدئة، ومعارضة الإحتمال إن أفادت شيئاً أفادت هناك.
وفيه أنّ الفرق أنّ الإمكان قبل الثلاثة غير مستقرّ وبعده يستقرّ والتجاوز عن العشرة وحدوث الزائد إن تحقّق فهو طريق آخر يعارض الإمكان الذي هو طريق إلى الحيضية، واحتمال حدوث الطريق والكاشف عن بطلان الطريق الموجود لا يوجب رفع اليد عن ذلك ما لم يتحقّق ذلك المعارض، نعم لو تحقّق لزم مراعاة الأقوى، والسرّ في جميع ذلك أنّ دون الثلاثة لا يحتمل الحيضية شرعاً والدم المتجاوز يحمل فيما دون العشرة منه الحيضيّة ولا يلزم منه مخالفة لدليل شرعي. نعم جعل الشارع التجاوز أمارة الى عدم كون المتجاوز حيضاً، وذلك واضح لا غبار عليه.
قولهقدسسره : « لو رأت الدم ثلاثة أيّام ثمّ انقطع ورأت قبل العاشر كان الكلّ حيضاً ».
أقول: لا إشكال في أنّه بناءً على أنّ أقل الطهر عشرة مطلقاً لا يجتمع الحكم بكون النقاء طهراً مع الحكم بكون الدم حيضاً فلا مناص عن الحكم إمّا على الدم بأنّه استحاضة أو على الطهر بأنّه حيض، والظاهر هو الثاني لقولهعليهالسلام في صحيحة ابن مسلم أو حسنته عن أبي جعفرعليهالسلام أنّه قال: إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الاولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة(١) دلّ على أنّ الدم الثاني حيض، فالنقاء كذلك لما مرّ من الملازمة، وبهذا التقريب يدلّ على المدّعى كلّ ما دلّ على أنّ الدم الثاني حيض كقاعدة الإمكان.
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب ان اقل الطهر بين الحيضتين عشرة ايام ح ٣ ، ج ٢، ص ٥٥٤.
والحاصل أنّ كلّ دمين كان بينهما نقاء ولم يزد المجموع عن العشرة وكان الكلّ حيضاً إذا ثبت حيضيّة الدم الأوّل ولو بقاعدة الإمكان، ولا يتوهّم أنّ التمسّك بقاعدة الإمكان الحكم [بحيضية] الدم الثاني في غير محلّه، نظراً إلى أنّ الكلام في حكم النقاء والدم الثاني من حيث مانعية الثاني عن كون الأوّل طهر والأوّل عن كون الثاني حيضاً، إذ الظاهر أنّه لا إشكال في أنّ التوالي بعد الثلاثة غير معتبر في الحيض، وانّما الكلام في الشبهة الخارجية بعد إجتماع شرائط الإمكان، فالمسألة من فروع قاعدة الإمكان كالمسألة الاولى، بل لولا قاعدة الإمكان لأشكل التمسّك بالحسنة السابقة(١) من حيث أنّ الظاهر كونها في بيان أنّ الدم الثاني من الحيضة الاولى بعد الفراغ عن حيضيه ذلك الدم، ولا يحتاج الفقرة الثانية إلى تقيّد كون الدم بعد حصول عشرة الطهر لأنّ ذلك من مقتضيات فرض الدم حيضاً، فلا إطلاق حتى يحتاج إلى قيد.
قولهقدسسره : « لو تأخّر بمقدار عشرة أيّام ثمّ رأت كان الأوّل حيضاً منفرداً والثاني يمكن أن يكون حيضاً مستأنفاً ».
أقول: مراده من إمكان كون الثاني حيضاً احتماله يعني أنّه يحتمل فيه الحيضة المستقبلة بأن يحصل شرائطه ويرتفع موانعه، وربما يتخيّل أنّ المراد الحكم بحيضيّة هذا الدم تمسّكاً بقاعدة الإمكان، فعبّر عن الحكم بدليله، وهو وهم فأنّ إطلاق الحكم بذلك حتى مع استقرار الإمكان ينافي تردّده في المبتدئة والمضطربة.
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب اقل الطهر بين الحيضتين عشرة ايام ج ٢، ح ٢، ص ٥٥٤.
قوله:قدسسره : « الثالثة: إذا انقطع الدم لدون العشرة فعليها الاستبراء بالقطنة ».
أقول: الاستبراء هو طلب براءة الرحم من الدم، والظاهر أنّ المناط في كون المرأة حائضاً جريان الدم من الرحم إلى فضاء الفرج، وليس وجوده في الرحم موجباً لذلك وإن لم يخرج، ذلك لمّا كان الغالب أنّ الدم متى كان شيء منه في الرحم خرج إلى الفضاء عبّر عن اعتبار حال قذف الرحم الدم الى الفضاء بطلب براءة الرحم.
والحاصل أنّ المناط في كون المرأة حائضاً واقعاً بعد الثلاثة خروج الدم ولو في اليوم العاشر، وأمّا ظاهراً فمتى علمت بعدم قذف الرحم الدم فهي طاهرة، إلاّ أن تعلم بخروج الدم بعد ذلك، ويدلّ على ذلك كثير من الأخبار وسيأتي بعضها في باب الاستظهار، فإذا رأت النقاء بظاهر حالها ولم تعلم انقطاع الدم من الباطن أو عدمه اعتبرت ذلك بالاستبراء وجوباً كما هو المشهور، بل المحكي عن الذخيرة(١) نسبته إلى الأصحاب، وعن الحدائق(٢) أنّ الظاهر أنّه لا خلاف فيه، ولكن عن الاقتصاد(٣) التعبير بلفظ ينبغي الظاهر في الاستحباب، ويمكن حمله على الوجوب.
ويدلّ على ذلك أخبار كثيرة ففي صحيحة ابن مسلم: إذا رأت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل، وإن لم تر شيئاً فلتغتسل، فإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصلّ(٤) .
____________________
(١) الذخيرة: في احكام الحيض ص ٦٩، س ١٥.
(٢) الحدائق: في استظهار ذات العادة ج ٣، ص ٢١٦.
(٣) الاقتصاد: في ذكر الحيض والاستحاضة ص ٢٤٦.
(٤) وسائل الشيعة: ب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة ح ١، ج ٢، من ٥٦٢ باختلاف.
ومرسلة يونس عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا؟ قال: تقوم قائمة وتلزق بطنها وتستدخل قطنة بيضاء وترفع رجلها اليمين فإن خرج على القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر، وإن لم يخرج فقط طهرت تغتسل وتصلّي(١) .
ورواية شرحبيل الكندي قال: قلت لأبي عبد اللّهعليهالسلام : كيف تعرف الطامث طهرها؟ قالعليهالسلام : تعمل برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمين فإن كان ثمّ مثل رأس الذباب خرج عن الكرسف(٢) .
وموثقة سماعة قلت: المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا؟ قالعليهالسلام : فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على الحائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ثمّ تستدخل الكرسف، فإذا كان ثمّة من الدم مثل رأس الذباب خرج، فإن خرج دم فلم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت(٣) .
وعن الفقه الرضوي: وإذا رأت الصفرة أو شيئاً من الدم فعليها أن تلصق بطنها الى حائط، وترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب إذا بال، وتدخل قطنة، فإن خرج دم فهي حائض، وإن لم يخرج فليست بحائض(٤) .
وقد يشكل التمسّك بالأخبار المذكورة لإثبات الوجوب نظراً إلى أنّ بعضها لبيان كيفية استعلام براءة الرحم من غير تعرّض لوجوبه كمرسلة يونس(٥) وبعضها للإرشاد لئلاّ يقع الغسل وما يترتّب عليه من الأعمال لغواً كصحيحة محمد بن مسلم(٦) .
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع ح ٢، ج ٢، ص ٥٦٢.
(٢) وسائل الشيعة: ب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع ح ٣، ج ٢، ص ٥٦٢.
(٣) وسائل الشيعة: وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع ح ٤، ج ٢، ص ٥٦٢.
(٤) فقه الرضا: باب الحيض والاستحاضة والنفاس و. ص ١٩٣.
(٥) وسائل الشيعة: ب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة ح ٢، ج ٢، ص ٥٦٢.
(٦) وسائل الشيعة: ب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة ح ١، ج ٢، ص ٥٦٢.
وتوضيحه أنّ الأمر بالاستبراء إمّا شرطي لبيان اعتبار ما يترتّب عليه من الجزم ببراءة الرحم فعلاً في صحّة الغسل، ويلزمه أنّ الطاهر في الواقع إن اغتسل شاكّاً فسد غسله، وإمّا للوجوب تعبّداً من غير إرتباط له بالعادة وجوداً وعدماً، ويلزمه صحّة الغسل من الطاهر إذ بني الغسل على أصل من الاصول، وإمّا للوجوب والغرض من تعيين الطريق إلى معرفة حال المرأة من كونها حائضاً أو طاهرة، ومرجعه إلى النهي عن الاتكال بالنقاء الظاهري في الحكم بحصول الطهارة، ويلزمه إلغاء الأصل في إثبات الموضوع سواء كان مقتضاه ثبوت الحيض أو النقاء، فأنّ تعيين الاعتبار في مجرى الأصل يلزمه إلغاء الأصل، ومقتضى ذلك أن لا يحكم بصحّة الغسل ظاهراً إلاّ بعد القطع بحصول البراءة إذ لم يحرز الأمر به الموجب لصحته إن وقع جامعاً لشرائطها، بل الظاهر عدم تأتي قصد القربة إلى فعل الغسل قبل الإستبراء إلاّ على وجه الاحتياط، ضرورة توقّفه على العلم بالأمر إمّا بالطريق الظاهر كالأصل والمفروض عدم اعتباره، أو بالطريق العقلي وهو تابع للقطع بالنقاء والمفروض عدمه، وإمّا للارشاد لئلاّ يقع الغسل وما يترتّب عليه لغواً إذا اتّفق خروج الدم بعد الغسل، ولا يترتّب على ذلك شيء ممّا ذكر في الوجوه المتقدّمة من فساد الغسل ظاهراً أو واقعاً، إذ لا تعرّض فيه لشرطيّة الظاهرية بإلغاء الاصول أو الواقعية.
فتلخص أنّ وجوب الاستبراء إمّا لأنّ الجزم ببراءة الرحم شرط في صحّة الغسل فلا يصحّ بدونه وإن ثبت وجوب الغسل ظاهراً بالأصل، وأمّا لأنّ الأصل الذي هو طريق إلى صحّة الغسل ظاهراً لا يعتبر به لتعيين الطريق في الاستبراء، ودلالة الأخبار قاصرة عن إفادة أحد هذين المعنيين، إذ عرفت إمكان دعوى كونها للإرشاد لئلاّ يلغو الغسل. ولكن يمكن أن يقال إنّ دلالة الأخبار مع ما فيها من الظهور في الوجوب في الجملة مجبورة لفهم الأصحاب، مؤيّداً بأن الأصل في أمثال المقام من الشبهات الموضوعية التي لا يعلم غالباً إلاّ بالفحص ويغلب من العمل بالأصل فيها بدون الفحص مخالفة كثيرة - بالنسبة إلى شخص واحد أو نوعاً - يشكل
التمسّك به خصوصاً مع إيجاب الفحص في كثير من الموارد التي تشبه المقام كمورد اشتباه دم الحيض بالعذرة أو القرحة ومورد اشتباه بعض أقسام الاستحاضة بالآخر، مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ مقتضى الأصل في محلّ الكلام هو الفحص نظراً لما أنّ أصالة بقاء الدم لكون الشكّ من جهة اقتضاء المقتضي لا يجوز التمسّك بها، وأصالة عدم حدوث الدم الزائد على القدر المعلوم لا يجري في المقام، لأنّه الحالة السابقة هي وجود الدم وخصوصية الدم الزائد ملغاة في نظر العرف بملاحظة أنّ الدم من الامور التدريجية التي يجري فيها استصحاب الوجود مسامحة، والحاصل أنّ كون الدم من الامور التدريجية القابلة لأن تستصحب وجودها مانع عن إجراء أصالة العدم وكون الشك في بقاء الدم من جهة اقتضاء المقتضي من جهة أنّ انقطاع الدم ليس لحدوث المانع وانّما هو غالباً لإنعدام مقتضي بقائه مانع عن أصالة بقاء الدم، ودوران الأمر بين وجوب العبادات وحرمة ما يحرم على الحائض مانع عن أصالة البراءة، فالمتعيّن في البناء على وجود الحيض وعدمه هو الفحص والاعتبار مع أنّ أصالة بقاء الدم على تقدير صحّة التمسّك بها تقتضي فساد الغسل ظاهراً ما لم يحصل القطع بالنقاء وان كان مقتضاها عدم وجوب الإستبراء أيضاً.
ثمّ إنّه لو اغتسل قبل الإستبراء ناسياً أو جاهلاً بوجوبه فتبين حصول النقاء قبل الغسل، فالظاهر صحّة الغسل بمعنى جواز البناء عليه بعد تبيّن النقاء، لأنّ صحّة الغسل واقعاً لا يعتبر فيها غير النقاء، والعلم به من الطريق الخاص أو مطلقاً لا يعتبر فيها، ووجوب الاستبراء انّما هو لتوقّف العلم بالأمر الذي لا طريق الى إحراز وجوده أو عدمه غير الاستبراء، ومنه ينشأ عدم الحكم بصحّة الغسل ظاهراً، وعدم تأتي الإتيان بالغسل بقصد الوجوب قبل الاستبراء، فإذا وقع الغسل بقصد الوجه وكان الواقعي في صحّته موجوداً أيضاً كما في المقام لم يكن وجه للفساد. نعم لو التفت بعد الغسل الى ترك الإستبراء ووجوبه لم نحكم بالصحّة ظاهراً إلى أن يتبيّن وقوع الغسل حال النقاء، وإحتمال أنّ الجزم بالنقاء معتبر في صحة الغسل واقعاً لا دليل عليه، وغاية ما يستفاد من الأخبار المذكورة على تقدير دلالتها على الوجوب
هو عدم جواز البناء على ظاهر الحال في الحكم بالنقاء، وذلك لا تقتضي شرطيّة الجزم بصحّة الغسل واقعاً.
ولو اغتسل عالماً بوجوب الإستبراء إحتياطاً ثمّ تبيّن حصول النقاء قبل الغسل بالإستبراء أو بوجه آخر ففي صحّة الغسل إشكال، لا لأنّ الجزم بالنقاء شرط في صحّة الغسل لما عرفت من أنّه لا دليل عليه، ولا لأنّ إيجاب الإستبراء قبل الغسل يدلّ على أنّ الجزم بوجوب الغسل معتبر في صحّته، لأنّ الأمر بالغسل في الأخبار المذكورة في قبال فعل الغسل بعنوان الوجوب والبناء على حصول النقاء نظراً إلى ظاهر الحال، وليس فيها دلالة على المنع عن الاحتياط مع البناء على الإستبراء بعده، بل لأنّ في أصل الاحتياط عند الشكّ في المطلوبية مع التمكّن من الفحص إشكالاً معروفاً، قال شيخناقدسسره في باب الإستحاضة: فمن اشتبه عليها الدم ولم تدر أنّه من أي الأقسام الثلاثة ففي كفاية الاحتياط من الاعتبار مطلقاً أو بشرط موافقته للاستصحاب وعدمها مطلقاً وجوه، خيرها أوسطها ثمّ أولها، أمّا كفاية الاستصحاب عنه مع مخالفته للاحتياط لو سبقت القلّة أو أصالة عدم زيادة الدم عن حدّي القلّة وإن لم يسبق فالأقوى العدم لمّا مرّ نظيره في الاستبراء، ولعلّه يستفاد من بعض أخبار المسألة انتهى كلامه جزاه اللّه تعالى عن أهل الإسلام خير الجزاء.
توضيح مراده أنّ الشاك في كون الاستحاضة قليلة أو كثيرة إمّا أن يكون له حالة السابقة(١) بالنسبة إلى القلّة أو الكثرة أو ليس له حالة السابقة(٢) ، فإن كان(٣) حالته السابقة هو(٤) القلّة لم يجز له الاكتفاء بالاستصحاب، لما مرّ من أنّ الأصل في الشبهة الموضوعية التي يلزم من العمل بالأصل فيها مع ترك الفحص
____________________
(١) و (٢) كذا في النسخة الخطية، والصحيح: سابقة.
(٣) كذا والصحيح: كانت.
(٤) كذا والصحيح : هي.
مخالفة كثيرة شخصية أو نوعية يشكل التمسّك، مضافاً إلى دلالة الأخبار على إيجاب الاعتبار، ولا الاكتفاء بالاحتياط لما مّر من أنّ العمل بالاحتياط مع الشكّ في الأمر والتمكّن من الفحص مشكل، نسب الى مشهور العلماء المنع عنه فتأمّل. ومثل هذه الصورة ما لو لم يكن له حالة سابقة، لأنّ أصالة البراءة عن ما يجب على الكثرة لا يجوز العمل بها، وإن كان حالته السابقة هو الكثرة فالاستصحاب لا مانع من العمل به، لأنّ وجوب الفحص في العمل بالأصل انّما يثبت إذ الزم من العمل بالأصل مخالفة الاحتياط.
وأمّا مجرّد عدم مطابقة الأصل للواقع فلا يمنع عن العمل بالأصل، وكذلك الاحتياط، لأنّ الاحتياط مع وجود الطريق الظاهري مطابقاً له أومخالفاً له لا مانع منه، واحتمال وجوب الاتيان بقصد الوجوب الظاهري لا وجه له، لأنّ دليل اعتبار الأصل يمنع عن مخالفته، والاحتياط لا يكون مخالفة للأصل، واعتبار الجزم الظاهري في صحّة العبادة مع سقوط اعتبار الجزم بالنسبة الى الأمر الواقعي كما هو لازم جواز العمل بالأصل لا دليل عليه، نعم لو قلنا إنّ قصد الأمر الواقعي جزما لازم حتى مع كون الأصل مقتضياً لوجوده كان الإتكال الى(١) الأصل باطلاً ولزم منه بطلان الإحتياط.
ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكرنا من جواز الإحتياط مع مطابقته للأصل بين المجتهد في الفتوى والمقلّد في العمل.
إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم إنّ الاحتياط في المقام يتصوّر على وجهين: أحدهما أن يأتي بالغسل باحتمال الأمر بانياً على الاستبراء بعده ليعلم حاله بالنسبة إلى هذا الغسل.
والثاني: أن يأتي بالغسل ويأتي بالعبادات الواجبة على الطاهر ويترك ما يحرم على الحائض إلى أن يحصل له العلم بحصول النقاء. والأصل في المقام - سواء
____________________
(١) كذا والصحيح: على.
كان هو الطهارة بناءً على أصالة عدم الدم الزائد أو الحيض بناءً على أصالة بقاء الدم - مخالف للاحتياط، لأنّه على الأوّل موجب لجواز محرّمات الحائض، وعلى الثاني موجب لجواز ترك واجبات الطاهر، فهو ساقط على الوجهين، وحينئذٍ فالإحتياط بكلا وجهيه باطل على الإشكال فيه عند التمكّن من تحصيل الطريق، إلاّ أن يقال: إنّ العمل بالأصل إذا كان(١) .
ولكنّ الإنصاف أنّ الحكم ببطلان الإحتياط إذا لم يحسب في نظر العرف لغواً مشكل، إذ لا دليل معتدّ به على منعه، ولكنّ الإحتياط في تركه.
ثمّ إنّه لو لم يتمكّن من الإستبراء والفحص فالظاهر جواز البناء على الأصل فيصير بناءً على أصالة بقاء الدم إلى أن يحصل له العلم بالنقاء، وتغتسل وتصلّي ما يخاف فوته من العبادات بناءً على أنّ الأصل هو النقاء.
ثمّ إن قلنا بوجوب الإستبراء فهل يجوز الاكتفاء بالظنّ بالنقاء لعادة أو لوجود الدم؟ لذلك وجهان أقواهما العدم.
وكيفية الاستبراء هو إدخال القطنة بأيّ وجه اتّفق ، و إن كان الأحوط هو العمل بموثقة سماعة(٢) ، بل لا يخلو عن قوّة، وأمّا رفع رجل(٣) اليسرى واليمنى فالظاهر عدم وجوبه، لأن المرسلة(٤) ورواية شرحبيل(٥) مع ما فيهما من الضعف متعارضتان.
ثمّ إن المحكي عن الرياض(٦) أنّها إذا [ أ ] دخلت القطنة صبرت هنيئة، والظاهر
____________________
(١) الظاهر سقوط عبارة هنا.
(٢) وسائل الشيعة: ب أستحباب استظهار ذات العادة، من أبواب الحيض، ح ١، ج ٢، ص ٥٥٦.
(٣) كذا والصحيح: الرجل.
(٤) وسائل الشيعة: ب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة ح ٢، ج ٢، ص ٥٦٢.
(٥) وسائل الشيعة: ب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة ح ٣، ج ٢، ص ٥٦٢.
(٦) لم نعثر عليه.
أنّ ذلك منصرف الإطلاقات، وإلاّ فالنصوص والفتاوى كما قيل(١) خالية عن ذلك.
قولهقدسسره : « فإن خرجت القطنة نقيّة اغتسلت ».
أقول(٢) : إذا خرجت القطنة نقيّة فإن علم العود فلا إشكال في أنّه لا يجب الغسل، ولو علم عدمه أو لم يعلم أحدهما، ولم يظنّ بالعود وجب الغسل والعبادة، وذلك في الصورة الاولى واضح.
ويدلّ على ذلك في غيرها؛ أصالة عدم حدوث الدم، ولا يعارضه أصالة بقاء الدم، وإن قلنا به في التدريجيات للقطع بالإنقطاع.
نعم يمكن أن يعارض ذلك بأصالة بقاء الحيض، أعني الأمر المشترك بين جريان الدم فعلاً ووجوده في أثناء العشرة من مبدأ الدم، وفيه تأمّل.
وإطلاق ما مرّ من قولهعليهالسلام : فإن لم تر شيئاً فلتغسل(٣) وقولهعليهالسلام : وإن لم يخرج فقد طهرت(٤) وقولهعليهالسلام في مرسلة مولى أبي المغراء: إذا رأت الدم أمسكت، وإذا رأت الطهر صلّت(٥) .
مضافاً إلى عدم الخلاف في ذلك، ولو ظنّ بالعود لعادة أو غيرها، فالأقوى إلحاقه بالشكّ لما مرّ.
____________________
(١) الذخيرة: في ادلة ثبوت الاستظهار ص ٧٠ ، س ١٣.
(٢) إلى هنا آخر ما موجود في نسخة طهران فقط، وبعده الى قوله: في ص ١١٤: مضافاً إلى النقض مشترك بين النسختين.
(٣) وسائل الشيعة: ب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع من كتاب الطهارة، ح ١، ج ٢، ص ٥٦٢.
(٤) وسائل الشيعة: ب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع من كتاب الطهارة، ح ٤، ج ٢، ص ٥٦٢.
(٥) وسائل الشيعة: ب حكم انقطاع الدم في أثناء العادة وعوده من كتاب الطهارة، ح ١، ج ٢، ص ٥٤٤.
وعن الدروس: الاستظهار هنا(١) .
وربما يؤيّد بلزوم الحرج.
ويمكن الفرق بين الظنّ الحاصل من العادة وغيرها، كما يظهر عن المدارك(٢) ، والذخيرة(٣) ، وحكي الجزم به عن جماعة(٤) منهم المحقّق البهبهاني، وعلّل للأوّل بما مرّ من لزوم الحرج، وبإطلاق ما دلّ على ترك العبادة في أيّام العادة(٥) ، وعلى ما هو المنساق منها عرفاً، وللثاني بالأصل وما مرّ.
والجواب أنّ المشقة في ذلك ليس بأزيد من أغسال المستحاضة، وبأنّ أدلّة العادة انّما يرجع إليها، في حكم الدم المعلوم المردّد بين الحيض وغيره كما هو واضح.
قوله «قدسسره »: « وإن كانت متلطّخة صبرت المبتدئة حتى تنقى، أو تمضي عشرة أيّام ».
أقول: إذا خرجت القطنة متلطّخة لم تطهر إذا احتمل بقاء الدم بعد خروجها كما هو الغالب، وإلاّ فلو قطع بعدم بقاء شيء بعد خروجها، فلا إشكال في أنّه يجب الغسل، ومع القطع بالبقاء تستبرئ حتى حصل احتمال الإنقطاع، وليس خروجها متلطّخة أمارة لعدم الانقطاع عند الشك، كيف وليس فيه كشف وأمارية، وأيضاً ولو كان أمارة لكان أمارة لعدم الطهر في زمان معيّن، كما هو واضح، وليس هنا زمان معيّن إلاّ أقصى الحيض، ومعلوم أنّ تلطّخ القطنة ليس أمارة لبقاء الدم في تلك المدّة.
____________________
(١) الدروس: كتاب الطهارة، ص ٦ ، س ٢١.
(٢) مدارك الاحكام: كتاب الطهارة، ص ٦٣، س ٧.
(٣) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة، ص ٦٩، س ٤٣.
(٤) حاشية البهبهاني على مدارك الاحكام، ص ٧١ ، س ٣٦.
(٥) حاشية البهبهاني على مدارك الأحكام، ص ٧١، س ٣٦.
نعم يمكن أن يقال: إنّ وجوب الاستبراء عند احتمال النقاء مطلقاً حرج، فلابدّ إمّا من تقييده بالظنّ بالنقاء لعادة أو غير ذلك، أو بما لم يظنّ بقاء الدم، وكيف كان إذا خرجت القطنة متلطّخة صبرت المبتدئة حتى تنقى، أو بمضيّ عشرة أيّام اجماعاً؛ حتى من القائلين بعدم اعتبار الإمكان في حيضية الدم.
ويدلّ عليه قبل الإجماع، مضافاً إلى قاعدة الإمكان، موثّقة ابن بكير(١) ، ومضمرة سماعة، عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة يختلط عليها، لا يكون طمثها في الشهر عدّة أيّام سواء قال: فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة(٢) .
ولا يقدح فرض الحيض في السؤال يومين، لأنّ المقصود بيان الاختلاف، مع أنّه يمكن توجيهه. بحيث لا ينافي اعتبار الثلاثة، والظاهر أنّ مراد المصنّف من المبتدئة بالمعنى الأعم، كما هو مقتضى المضمرة وقاعدة الإمكان، وأيضاً محلّ الكلام هو التحيّض إلى العشرة، وأمّا إذا تجاوز الدم عن العشرة ففي جعل تمام العشرة، حيضاً، أو الرجوع الى التميّز وما بعده كلام، لعلّه يأتي الإشارة إليه، إن شاء اللّه تعالى.
قولهقدسسره : « وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها، فإن استمرّ إلى العاشر وانقطع قضت ما فعلته من صوم، وإن تجاوز كان ما أتت به مجزياً ».
أقول: لا إشكال في أنّ الاستظهار مشروع لذات العادة. ويدلّ عليه قبل
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب وجوب رجوع المبتدأه الى التمييز من أبواب الحيض، ح ٥ ، ج ٢ ، ص ٥٤٩.
(٢) وسائل الشيع: ب ثبوت عدة الحيض باستواء شهرين من كتاب الطهارة، ح ١، ج ٢، ص ٥٤٥.
الإجماع أخبار كثيرة تبلغ حدّ التواتر، وهو طلب ظهور حال الدم بترك العبادة يوماً أو يومين(١) .
وانّما الإشكال في مقامين:
أحدهما: أنّه هل على الوجوب، أو الاستحباب، أو الاباحة ؟
وثانيهما: أنّه كم تستظهر التي تجاوز الدم عادتها ؟
فنقول: حكي عن ظاهر الشيخ في النهاية(٢) ، والجمل(٣) ، والمرتضى في المصباح(٤) الوجوب، وقيل(٥) : بالاستحباب، ونسب ذلك إلى عامّة المتأخرين(٦) ، وليس في عبارة المصنّف هنا ما يشهد بموافقته لشيء من الأقوال، فانّ وجوب الغسل بعد الأيام المذكورة لا يدلّ إلاّ على عدمه فيها.
حجّة القائلين بالوجوب امور
الأوّل: الأصل، وهو أصالة بقاء دم الحيض، وعورض بأصالة بقاء الدم الى ما بعد العاشر المستلزم لعدم كونه حيضاً شرعاً. وردّ بأنّ المرجع بعد تسليم المعارضة الى استصحاب أحكام الحيض، لا نفس الموضوع.
قلت: أمّا التمسّك بأصالة بقاء دم الحيض، فمع ابتنائه على جريان الأصل في الأمور التدريجية، يرد عليه أنّ الشكّ هنا في اقتضاء المقتضي، فانّ انقطاع دم الحيض غالباً لعدم بقاء المقتضي لجريان، وإمكان الحيض الى العشرة لا يثبت المقتضي.
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب استحباب استظهار العادة من كتاب الطهارة، ج ٢، ص ٥٥٦ - ٥٥٨. انظر الباب.
(٢) النهاية: كتاب الطهارة، ب حكم الحائض والمستحاضة ، ص ٢٤، س ٩.
(٣) الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشرة) فصل في ذكر الحيض، ص ١٦٣ ، س ٧.
(٤) المعتبر: ٥٧.
(٥) رياض المسائل: ج ١: ٤٢ مدارك الاحكام: ٤٩.
(٦) جامع المقاصد: ب الحيض وغسله، ص ٢٩٧، ج ١. ص١٣.
وأمّا المعارضة بأصالة بقاء الدم الى ما بعد العشرة، فمدفوعة:
أوّلاً: بأنّ التجاوز أمارة عدم كون الدم حيضاً، وليس ذلك من أحكامه.
فإن قلت: مستصحب العدالة يسمع خبره، وهل الخبر إلاّ طريقاً الى مدلوله، فإذا ثبت وصف الطريق بالاستصحاب، فكيف لا يثبت نفسه به؟
قلت: فرق بين الأمارات والطرق، فانّ ترتيب أحكام الواقع عند قيام الطريق، هو من أحكام الطريق ومعنى حجّيّته، وأمّا الأمارات فالمثبت للواقع فيها، هو الظنّ النوعي الحاصل من الملازمة الغالبيّة بين الأمارة وذي الأمارة، وذلك الظنّ تابع لوجود الأمارة في الخارج، وليس الوجود الاستصحابي كافياً فيه.
والحاصل: أنّ ترتيب أحكام الواقع ليس من أحكام نفس الأمارة، بل هو من أحكام لازمها، أعني الظنّ النوعي الحاصل منها بمعونة الغلبة، فأصالة بقاء الأمارة بالنسبة الى أحكام ذي الأمارة مثبت، لا يعتنى به، كما قرّر في محله.
وثانياً: بعد تسليم كون عدم حيضية ذلك الدم من أحكام التجاوز، إلاّ أنّ التجاوز لا يثبت بالأصل.
وبعبارة اخرى: إن كان ذلك حكماً لوجود الدم بعد العشرة، أعني وجوده الخارجى، فلم يعقل ثبوت هذا الحكم قبل العشرة، ولو كان التجاوز معلوماً، لأنّ الحكم لا يتقدّم على موضوعه، وإن كان حكماً لكون الدم ممّا يوجد بعد العشرة، فأصالة بقاء الدم الى ما بعد العشرة، لا يثبت كون الدم ممّا يوجد بعد العشرة.
وبعبارة ثالثة: أصالة بقاء الدم إلى ما بعد العشرة يثبت وجوده بعده، ويترتّب عليه آثار وجوده، وأمّا بقاؤه وآثار بقائه واستمراره فلا يثبت به، فافهم، فانّه لا يخلو عن دقّة.
وثالثاً: بأنّ الرجوع إلى العادة حكم من اختلط حيضها باستحضاتها، وهذا الموضوع انّما يتحقّق بعد تجاوز الدم واقعاً، لا استصحاباً، فافهم.
وأمّا ما أورد على المعارضة فيرد عليه.
أوّلاً: أنّه بعد التسليم، يكون ذلك الاستصحاب حاكماً على أصالة بقاء الدم،
لأنّ معنى الحكم بكون الدم المتجاوز إستحاضة، أنّ الحيض منقطع على العادة شرعاً، ولا يعتنى بالأصل المقتضي لبقائه، فيجب عدم الاعتناء بأصالة بقاء الحيض عند ثبوت التجاوز، سواء كان المثبت له طريقاً عقلياً، أو أصلاً تعبّدياً، ولا يتخيّل العكس هنا، ولا يخفى وجهه.
وثانياً: أنّ استصحاب الحكم تابع لبقاء موضوعه، والفرض أنّه مشكوك البقاء.
فإن قلت: المراد من الحكم المستصحب ليس هو الأحكام التكليفية الثابتة للحائض، بل المراد هو الحالة الحادثة في الحائض، لسبب خروج الدم الباقية ببقاء الحيض الشرعي، أعني القدر المشترك بين سيلان الدم متّصلاً وخروجه بعد تحقق الثلاثة المتوالية في أثناء العشرة ولو بعد النقاء.
قلت: أوّلاً: أنّ الذي يتعقل تحقّقه أمران: الحيض الشرعي، والحدث المانع عن العبادة المرتفع بالغسل عند انقطاع الحيض، فإن كان المستصحب هو الأوّل فليس ذلك إلاّ نفس الموضوع، وإن كان الثاني فهو، وإن كان من مقولة الأحكام الوضعية، إلاّ أنّ بقاءه، لا يفيد وجوب الاستظهار.
وثانياً: سلّمنا أنّ في المرأة تحدث بالحيض قذارة غير الحدث المانع عن العبادة لكن استصحاب بقاء الدم الى ما بعد العشرة يعارضه، وليس ذلك حكماً شرعياً متأخّراً عن الحيض، كتأخّر الحكم عن موضوعه، لتبقى أصالة بقائه سليماً عن المعارض بعد سقوط أصالة بقاء الموضوع بالمعارضة، بل هو أثر من آثار الحيض كشف عنه الشارع، وكلّما يعارض به أصالة بقاء الحيض معارض لأصالة بقاء ذلك.
والحاصل: أنّ مرجعية الاستصحاب للإستصحابين المتعارضين منوطة بالترتّب الشرعي دون الخارجي، فافهم. هذا مع أنّ أصالة عدم خروج دم الحيض، زائداً على القدر المعلوم إلى إنتهاء العشرة حاكمة عليه.
الثاني: قاعدة الإمكان.
واجيب عنه أوّلاً: بأنّ قاعدة الإمكان انما استفيد من الإجماعات المحكيّة، والمفروض أنّ المشهور بين المتأخرين عدم الحكم بالحيضيّة في المقام، وجعل الاستظهار مستحبّاً.
وثانياً: بأنّ قاعدة الإمكان - كما تقدّم في محلّه - لا تجدي في التحيّض بدم متزلزل تحتمل ظهور كونها المستحاضة، لعدم استقرار الإمكان.
ويمكن المناقشة في الأوّل: بأن الإجماع على القاعدة، بمعنى أنّ الأصل في الدم الممكن الحيضيّة أن يكون حيضاً، إلاّ أن يقوم دليل شرعي على أنّه ليس بحيض، ومثل هذا الاجماع لا يوهن بشهرة الفتوى بعدم حيضيّة دم خاص لظن كذا دليل خاص معلوم حاله، كأخبار الاستظهار(١) .
والحاصل: أنّ القاعدة بمنزلة العام ما لم يقم دليل على تخصيصه. إلاّ أن يقال: إنّ ظاهر المجمعين هو دعوى الإجماع على الكليّة، دون القاعدة بمعنى الأصل، فالشهرة على خلاف مقتضى القاعدة في مورد موهنة لتحقّق الإجماع في ذلك المورد.
وفي الثاني: بأنّ تزلزل الدم بين كونه حيضاً مع ظهور عدمه، قد يكون للشك في تمام شرائط الحيض الواقعيّة، وقد يكون لإحتمال قيام أمارة معتبرة حاكمة على قاعدة الإمكان، كالتميّز والعادة عند تجاوز الدم مثلاً، والتزلزل بالمعنى الثاني لا ينافي استقرار الإمكان، كيف ولو بني على ذلك لم يجز الحكم على ما تراه بعد الثلاثة وقبل العشرة بأنّه حيض، إلاّ إذا قطع بعدم التجاوز، أو عدم حصول التميّز على تقديره، ولا أظنّ المستدلّين بهذه يلتزمون بذلك.
ثمّ إنّه لا ينافي ما ذكرنا من تقدّم التميّز على القاعدة كون القاعدة كلّيّة يوهن كلّيّتها الشهرة على الخلاف، للفرق بين قولنا: كلّ دم مشكوك الحيضيّة حيض،
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب استحباب أستظهار ذات العادة مع أستمرار الدّم من أبواب الحيض، ج ٢، ص ٥٥٦ - ٥٥٨، انظر الباب.
وهذا المشكوك لا يجب الحكم بحيضيّته، وبين قولنا: كلّ دم مشكوك حيض، والتجاوز أمارة كون الدم استحاضة، فانّ التنافي بين الفقرتين الأولتين واضح كوضوح عدمه في الأخيرتين، فافهم فانّه لا يخلو عن شوب دقة.
الثالث: ما تقدّم في رواية محمّد بن مسلم من أنّ ما تراه قبل العشرة حيض(١) . وفي أخبار الاستبراء من أنّه متى خرجت القطنة ملوّثة لم تطهر خرج ما بعد العشرة(٢) .
والجواب عن رواية ابن مسلم يظهر ممّا تقدّم. وعن أخبار الاستبراء، بأنّ مصبّها الشكّ في وجود دم لو وجد كان حيضاً قطعاً، فلا تعلّق لها بالمقام، ثمّ لا يذهب عليك أنّ مقتضى هذه الأدلّة - على تقدير تماميّتها - هو الحكم بكون ما بعد العادة حيضاً، والقائل بوجوب الاستظهار لا يلتزم به. وسيأتي توضيحه إن شاء اللّه تعالى.
الرابع : ظاهر كثير من أخبار الاستظهار: كموثقة مالك بن أعين: عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم، قال: نعم إذا مضى له منذ يوم وضعت، بقدر أيّام حيضها، ثم تستظهر بيوم، فلا بأس أن يغشاها إن أحبّ(٣) .
وموثقة زرارة: تقعد النفساء أيّامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين(٤) .
وصحيحة زرارة: قلت له: النفساء متى تصلّي ؟ قال: تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلاّ اغتسلت - إلى أن قال - قلت: والحائض؟ قال: مثل ذلك سواء(٥) .
وفي موثقة سماعة: فإن كانت أكثر من أيّامها التي تحيض فيهنّ، فلتتربّص
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام، ح ٣، ص ٥٥٤.
(٢) وسائل الشيعة: ب وجوب أستبراء الحائض من أبواب الحيض، ج ٢، ص ٥٦٢، انظر الباب.
(٣) وسائل الشيعة: ب أن أكثر النفاس عشرة أيام من أبواب الحيض، ح ٤، ص ٦١٢.
(٤) وسائل الشيعة: ب أن أكثر النفاس من أبواب الحيض، ح ٥، ص ٦١٢.
(٥) نفس المصدر السابق والباب، ح ٢، ص ٦١١.
ثلاثة أيّام بعدما تمضي أيّامها، فإذا تربّصت ثلاثة أيّام ولم ينقطع الدم عنها، فلتصنع كما تصنع المستحاضة(١) .
وفي موثقته الاخرى: فإذا زاد الدم على الأيّام التي كانت تقعد، استظهرت بثلاثة أيّام ثم هي مستحاضة(٢) .
وكموثّقة زرارة عن الطامث تقعد بقدر أيّامها كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين(٣) .
وفي رواية حمران بن أعين المرويّة عن المنتقى قلت: فما حدّ النفساء؟ قالعليهالسلام : تقعد أيّامها التي كانت تطمث فيهنّ أيّام أقرائها(٤) ، فان هي طهرت وإلاّ استظهرت بيومين أو ثلاثة(٥) .
وكصحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه وعلى آبائه وأبنائه السلام، قال: سألته عن الطامث كم تستظهر؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة(٦) .
وموثّقة يونس بن يعقوب، عن امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلّي؟ قال: تنتظر عدّتها التي كانت تجلس، ثمّ تستظهر بعشرة أيّام(٧) .
وفي رواية أبي بصير: النفساء إذا ابتلت بأيّام كثيرة مكثت مثل أيّامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيّامها(٨) . إلى غير ذلك من الأخبار،
____________________
(١) نفس المصدر السابق ، ب أستحباب استظهار ذات العادة من أبواب الحيض، ح ١، ص ٥٥٦.
(٢) وسائل الشيعة: ب أستحباب أستظهار ذات العادة من أبواب الحيض، ح ٦، ج ٢، ص ٥٥٧.
(٣) وسائل الشيعة: ب أستحباب أستظهار ذات العادة من أبواب الحيض، ح ١٣، ج ٢، ص ٥٥٨.
(٤) في المصدر: قرئها.
(٥) وسائل الشيعة: ب أن أكثر النفاس عشرة من أبواب النفاس، ح ١١، ج ٢، ص ٦١٤.
(٦) وسائل الشيعة: ب أستحباب أستظهار ذات العادة من أبواب الحيض، ح ٩، ج ٢، ص ٥٥٧.
(٧) وسائل الشيعة: ب استحباب أستظهار ذات العادة من أبواب الحيض، ح ١٢، ج ٢، ص ٥٥٨.
(٨) وسائل الشيعة: ب أن أكثر النفاس عشرة من أبواب النفاس، ح ٢٠ ج ٢، ص ٦١٦.
وسنتلو عليك بعضها في أثناء الكلام إن شاء اللّه تعالى. وهذه كما ترى مع أختلافها في تقدير الاستظهار، أغلبها ظاهر في الوجوب، إلاّ أنّ بازائها أخباراً كثيرة ظاهرة في عدم الوجوب، بل وأصل المشروعية، مثل قولهعليهالسلام في مرسلة يونس الطويلة الصريحة في المستحاضة المعتادة: لا وقت لها إلاّ أيّامها(١) .
وقولهعليهالسلام فيها أيضاً: تعمل عليه وتدع ما سواه، وتكون سنّتها فيما يستقبل إن استحاضت(٢) .
وفيها أيضاً: في المضطربة المأمورة بالتحيّض سبعاً ألا ترى أنّ أيّامها لو كانت أقلّ من سبع لما قال لها تحيّضي سبعاً(٣) ، فيكون قد أمرها بترك الصلاة أيّاماً وهي مستحاضة، ولو كان حيضها أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض. فإن المستفاد منه أنّ الشارع لم يكن ليأمر بترك الصلاة بعد العادة.
ومثل صحيحة معاوية بن عمار: المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها ولا يقربها بعلها، وإن جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت وصلّت(٤) .
وكموثقة سماعة: المستحاضة تصوم شهر رمضان إلاّ الأيّام التي كانت تحيض فيها(٥) .
ورواية ابن أبي يعفور: المستحاضة إذا مضت أيّام قرئها اغتسلت واحتشت(٦) .
ورواية مالك بن أعين: عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال: ينتظر
____________________
(١) و (٢) و (٣) : وسائل الشيعة: ب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة، من أبواب الحيض، ح ١، ج ٢، ص ٥٤٢.
(٤) وسائل الشيعة: ب الأستحاضة أقسامها وجملة من أحكامها، من أبواب الأستحاضة، ح ١، ج ٢، ص ٦٠٤.
(٥) وسائل الشيعة: ب عدم تحريم الصلاة والصوم، من أبواب النفاس، ح ١، ج ٢، ص ٦٠٩.
(٦) وسائل الشيعة: ب الاستحاضة أقسامها وجملة من أحكامها، من أبواب الاستحاضة، ح ١٣، ج ٢، ص ٦٠٨.
الأيّام التي كانت تحيض فيها، وحيضها مستقيمة فلا يقربها في عدّة تلك الأيّام(١) .
وفي مرسلة يونس القصيرة: كلّما رأت المرأة أيّام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، وكلّما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض(٢) .
وفي المستفيضة: الصفرة بعد الحيض ليس من الحيض(٣) .
وعن المبسوط: أنّه روي عنهمعليهمالسلام : أنّ الصفرة في أيّام الحيض حيض، وفي أيّام الطهر طهر(٤) .
ويمكن الجواب عنها: أمّا عن الفقرة الأخيرة من رواية يونس فبأنّ الحكم بالحيضية الواقعية فيما ليس بحيض، وكذا عكسه على وجه لا ينكشف خلافه، ويلزم منه فوت الواجب رأساً، أو الوقوع في الحرام غير الأمر بالاحتياط، ترجيحاً لجانب بعض الاحتمالات على بعض الى أن تطهر، فيترتّب عليه حينئذٍ آثار الواقع من قضاء ما فات وغيره. والذي دلّ(٥) الرواية على نفيه هو الأوّل دون الثاني.
وأمّا عن الفقرتين الأوّلتين، فبأنّ الظاهر أنّ انحصار الوقت في الأيّام، ووجوب العمل عليها، انّما هو في صورة استمرار الدم وتجاوز عن حدّ إمكان الحيض، وهذا لا كلام ولا إشكال فيه.
وأمّا عن الأربعة السابقة على المرسلة القصيرة، فبأنّ الظاهر أنّها في الدامية التي لا تطهر، ويشهد لذلك، موثقة ابن سنان: في المرأة المستحاضة التي لا تطهر، قال: تغتسل عند صلاة الظهر - إلى أن قال -: لا بأس يأتيها بعلها متى شاء إلاّ أيّام أقرائها(٦) .
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب حكم وطي المستحاضة، من أبواب النفاس، ح ١، ج ٢، ص ٦٠٩ و ٦١٠.
(٢) وسائل الشيعة: ب ان الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي ايام الطهر طهرا، ح ٣ ، ج ٢، ص ٥٤٠.
(٣) المصدر السابق: ب السابق والرواية السابقة في الهامش ٥.
(٤) المبسوط: فصل في ذكر الحيض والأستحاضة، من كتاب الطهارة، ص ٤٤، س ٩.
(٥) كذا في النسخة الخطية والصحيح: دلّت.
(٦) وسائل الشيعة: ب الأستحاضة أقسامها، من أبواب الأستحاضة، ح ٤، ج ٢، ص ٦٠٥.
وأمّا عن المرسلة فبأنّها مخصّصة بالمنقطع على العشرة، فلا يجوز التمسّك بها على حكم ما يشكّ في انقطاعه عليه، فانّ الرجوع إلى العلم في الشبهات المصداقية، ليس بأولى من الرجوع الى الخاص، كما قرّر في محلّه.
ودعوى أنّ المرسلة ظاهرة في حكم العمل فمحصّل مدلولها: أنّه يجب أن يعامل مع الذي بعد العادة معاملة عدم كونه حيضاً إلى أن ينكشف الخلاف، والحكم بالحيضيّة الواقعيّة على المنقطع لا ينافي ذلك، فلا تخصّص المرسلة أدلّتها.
مدفوعة بأنّ ظاهر القضية هو نفي الحيضيّة الواقعيّة، وحملها على حكم العمل يحتاج إلى شاهد، هذا مع أنّه ليس من البعيد أن يقال فيها أيضاً: أنّها في الدامية التي استمرّ دمها، وعلى فرض التسليم فيجب تخصيصها بأخبار الاستظهار، فانّها أخصّ من المرسلة مطلقاً.
وأمّا أخبار الصفرة فمحمولة على غير أيّام الاستظهار، ويشهد لذلك قولهعليهالسلام في رواية أبي بصير: ما كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض.
وقد ذكر للجمع بين هذه الأخبار وجوه اخر:
منها: حمل ما دلّ على وجوب الاستظهار على ما كان بصفة الحيض، وما دلّ على عدمه على ما كان بغير صفته، وذلك إمّا لتخصيص أخبار الاستظهار أوّلاً بما دلّ على أنّ الصفرة بعد الحيض ليس من الحيض فيصير بعد التخصيص أخصّ ممّا دلّ على وجوب الغسل بعد أيّام العادة فيخصّص بها، أو لشهادة صحيحة ابن مسلم عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها، قالعليهالسلام : لا تصلّي حتى تنقضي أيّامها، فإذا رأت الصفرة في غير أيّامها توضأت وصلّت(١) .
ويؤيّده عموم(٢) ما دلّ على اعتبار الصفات، وخصوص مرسلة يونس الواردة
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض، من أبواب الحيض، ح ١، ج ٢، ص ٥٤٠.
(٢) وسائل الشيعة: ب ما يعرف به دم الحيض من دم الأستحاضة، من أبواب الحيض، ح ٢، ج ٢، ص ٥٣٧.
في الاستبراء لمن انقطع عنها الدم ظاهراً، ولا تدري أطهرت أم لا، قال: تقوم قائمة وتلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء، فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت(١) .
ويرد على ذلك، مضافاً إلى أنّ في أخبار الاستظهار وما يأبى عن ذلك - كرواية سعيد بن يسار عن المرأة تحيض ثمّ تطهر، وربما رأت بعد ذلك الشيء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها، قالعليهالسلام : تستظهر بعد أيّامها بيومين، أو ثلاثة، ثمّ تصلّي(٢) - أنّ تخصيص أخبار الاستظهار بأخبار الصفرة بعد الحيض، بعد كون النسبة بينهما عموماً من وجه، لا وجه له، وأيضاً فرض أخبار الاستظهار خاصّاً، بالنسبة إلى الأخبار المانعة، بملاحظة هذا التخصيص لا وجه له.
وأمّا أخبار الصفرة(٣) من الصحيحة وغيرها، فمحمولة على ما بعد أيّام الاستظهار، وأمّا الوصف في خبر الاستبراء، وارد مورد الغالب ، مع أنّ حمل أخبار المنع على الصفرة بعيد جدّاً، خصوصاً في المرسلة القصيرة(٤) مع صراحة صدرها في التعميم.
ومنها: حمل أخبار الاستظهار على من كانت عادتها غير مستقيمة، بأن تكون قد تزيد وتنقص، وهذا لا ينافي كون المرأة معتادة عددية، إذ المقصود اختلاف أيّامها بالزيادة عليها أحياناً بعد استقرار العادة على عدد معيّن، وحمل أخبار الاغتسال بمجرد انقضاء العادة على من لا يكون في عادتها اختلاف أصلاً، كما هو مورد رواية مالك بن أعين(٥) .
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب وجوب أستبراء الحائض، من أبواب الحيض، ح ٢، ج ٢، ص ٥٦٢.
(٢) وسائل الشيعة: ب أستحباب أستظهار ذات العادة، من أبواب الحيض، ح ٨، ج ٢، ص ٥٥٧.
(٣) وسائل الشيعة: ب أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض، من ابواب الحيض، ج ٢، ص ٥٤٠ و ٥٤١، انظر الباب.
(٤) وسائل الشيعة: ب ان الصفرة والكدرة في ايام الحيض، من ابواب الحيض، ح ٣ ، ج ٢، ص ٥٤٠.
(٥) وسائل الشيعة: ب حكم وطي المستحاضة، من أبواب الأستحاضة، ح ١، ج ٢، ص ٦٠٩
ويشهد لهذا الجمع موثّقة البصري عن المستحاضة أيطؤها زوجها؟ وهل تطوف بالبيت؟ قال: تقعد أيّام قرئها التي كانت تحيض فيه، فإن كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به، وإن كان فيه خلاف، فلتحتط بيوم أو يومين(١) .
وفيه: مع بعد هذا الحمل، أنّ مورد الموثّقة هو الدامية اليائسة عن انقطاع الدم، ولا يخفى أنّ أخبار الاستظهار بين ما هو ظاهر في غير الدامية، وبين ما هو ظاهر في غير اليائسة، فانّ الاستظهار ينافي اليأس كما سيأتي بيانه.
ومع فرض تسليم ظهور الموثّقة في غير اليائسة، بملاحظة حمل الاحتياط على الاستظهار، يكون أخصّ من الأخبار النافية للاستظهار في الدامية، ومن الأخبار المثبتة لها دون غيرها من أخبار الاستظهار، فينحصر شهادة الموثّقة للجمع المذكور في الأخبار المختصّة بالدامية، والتزام الاستظهار في الدامية ولو في الجملة مشكل، بناءً على ما حكي عن بعض(٢) : أنّ محلّ الكلام في هذا البحث هو غير الداميّة، وأنّ ظاهر النص والفتوى اختصاص الاستظهار بالدورة الاولى.
ومن هنا ظهر أنّ العمل بالموثّقة في الدامية اليائسة أيضاً مشكل، بل فيها أشكل، فأنّ الاستظهار لها غير معقول، والاحتياط بترك العبادة لمجرد احتمال كون الدم حيضاً من غير مراقبة الانقطاع، لا يظنّ بالأصحاب أنّ يلتزموا به بل الأولى حمل الموثّقة على الاحتياط في خصوص موردها من الوطئ، وطواف البيت.
ومنها: حمل الأخبار المانعة على التقيّة.
ويرد عليه: أنّ تلك الأخبار موافقة لمذهب أكثر العامة من عدا مالك، والترجيح بمخالفة أكثرهم، إذا لم يظنّ بكون الموافق لهم تقيّة مشكل، والظنّ في تلك الأخبار بخلاف ذلك.
ومنها: إبقاء أخبار الاستظهار على ظاهرها من الوجوب، وجعلها مختصّة بصورة
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب اقسام ابواب الاستحاضة، ح ٨، ج ٢، ص ٦٠٧.
(٢) جواهر الكلام: ج ٣، ص ٢٠٥.
رجاء الانقطاع لدون العشرة، كما يشهد به قولهعليهالسلام في كثير منها: فإن رأت طهراً وانقطع اغتسلت، وإن لم ينقطع فهي مستحاضة(١) .
ويؤيّده مضافاً إلى التعبير عنه في بعض الأخبار بالإنتظار(٢) ، وفي بعضها الآخر بالاحتياط،(٣) ، الظاهر في احتمال كون الدم حيضاً بسبب انقطاعه قبل العشرة، أنّ الاستظهار طلب ظهور الحال في كون الدم حيضاً أو غيره، ولا معنى لطلب ذلك مع اليأس عن الانقطاع، ويحمل أخبار الاغتسال بعد العادة على اليائسة عن الإنقطاع، لانّ مواردها منحصرة في الدامية التي استمرّ بها الدم أشهر، أو سنين، بحيث يغلب على ظنّها عدم حصول الطهر بالصبر يوماً أو يومين، ومن هو مثلها كالنفساء، حيث إنّ الغالب استمرار دمها إلى ما بعد العشرة، ومثل النفساء من تعلّم عادة من جهة كمال استقامة عادتها، أنّ الحادث بعدها لا ينقطع على الشعرة فتزيد عادتها على حيضها، كما هو مورد مرسلة داود مولى أبي المغراء عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه [عليهالسلام ] قال: قلت: إمرأة يكون حيضها سبعة أيّام، أو ثمانية أيّام، حيضها دائم مستقيم، ثمّ تحيض فلم ينقطع عنها الدم، وترى البياض ولا صفرة ولا دماً، قالعليهالسلام : تغتسل وتصلّي - إلى أن قال -: فإذا مضت أيّام حيضها واستمرّ بها الطهر صلّت، وإذا رأت الدم فهي مستحاضة(٤) .
بقي الكلام في موثّقة البصري(٥) المتقدّمة؛ ويمكن القول بمقتضاها، بأن يكون اللازم أو الراجح للدامية التي قد تزيد حيضها على عادتها أن تحتاط في التحيّض بزيادة يوم أو يومين على عادتها، انتهى. وهذا الجمع أجود ممّا ذكرناه أوّلاً في جواب أخبار المنع: أنّه في أخبار الاستظهار ما يمكن دعوى ظهورها في الدامية،
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب أستحباب أستظهار ذات العادة، من أبواب الحيض، ح ٧ ، ج ٢ ، ص ٥٥٧.
(٢) وسائل الشيعة: ب أستحباب أستظهار ذات العادة، من أبواب الحيض، ح ١٠ ، ج ٢، ص ٥٥٧.
(٣) وسائل الشيعة: ب أستحباب أستظهار ذات العادة، من أبواب الحيض، ح ٧، ج ٢، ص ٥٥٧.
(٤) وسائل الشيعة: ب حكم أنقطاع الدمّ في أثناء العادة، من أبواب الحيض، ح ١، ج ٢، ص ٥٤٤.
(٥) وسائل الشيعة: ب اقسام ابواب الاستحاضة، ح ٨، ج ٢، ص ٦٠٧.
فلا محيض إلاّ بحملها على صورة رجاء الانقطاع، إلاّ أنّ في حمل تعليل مرسلة داود على اليائسة عن الانقطاع نظراً، فانّ دوام الاستقامة في العادة لا يوجب الظن بانّ الحادث بعدها تجاوز العشرة نعم يظنّ منه أنّه إستحاضة في الواقع.
فالاولى أن يعلّل لذلك بأنّ أخبار الاستظهار التي ظاهرة في غير الدامية أخصّ من المرسلة، وقد عرفت أيضاً أنّ الإلتزام بمقتضى موثّقة البصري مشكل. هذا وأجود من هذا الجمع، الجمع بين هذا وما ذكرنا.
ويجاب عن كلّ معارض بما يليق به.
أمّا مقدار الاستظهار: فقد اختلف فيه كلمات الأصحاب، فعن الصدوق: أنّه ثلاثة(١) ، وفي الإرشاد: أنّه يومان(٢) ، وعن المشهور: ما عليه المصنّف من التخيير بين اليوم واليومين، وقد عرفت اختلاف الأخبار في ذلك أيضاً.
وذكر للجمع بينها بعد جعل مدّة الاستظهار عشرة وجهان:
أحدهما: أنّ ظهور الحال الذي هو الغرض من الأمر بالاستظهار، قد يحصل بيوم واحد، وقد لا يحصل إلاّ بالصبر الى العشرة، فيكون ذكر العدد المعيّن كما في بعض الأخبار(٣) والمردّد كما في بعض آخر مثالاً لما يظهر به الحال حقيقة. فحاصل مفاد الأخبار أنّها تستظهر ما لم يصل الدم إلى العشرة، بما يظهر لها حال الدم، من حيث الانقطاع عليها والتجاوز عنها.
وثانيهما: أنّ ما يظهر به الحال بحسب عادات النساء مختلفة، فأنّ من كانت عادتها تسعاً، يظهر الحال لها بالصبر يوماً، وذات الثمانية بيومين، وهكذا، والكلّ محمول على الصبر إلى العشرة، والأخبار الأخيرة، لا يراد منها التخيير، بل المراد التنويع بحسب اختلاف العادات. وقد يوجّه الوجه الأخير بأنّ الأخبار الدالّة على
____________________
(١) الجوامع الفقهية (المقنع) : ب الحائض والمستحاضة والنفساء من كتاب الطهارة ص ٥، س ٢٠.
(٢) الارشاد: المقصد الثاني في الحيض، من كتاب الطهارة، ص ٢٢٧، س ١٢.
(٣) وسائل الشيعة: ب أستحباب أستظهار ذات العادة، من أبواب الحيض، ج ٢، ص ٥٥٦، انظر الباب.
الاستظهار بواحد، وإن كانت مباينة للأخبار الدالّة على الإنتظار إلى العشرة، لتوافقها في من كانت عادتها تسعاً، وتخالفها في غيرها، إلاّ أنّها مخصّصة بالأخبار الدالّة على الاستظهار بيومين، لأنّ تلك الأخبار بعد تقييدها بعدم زيادة مجموع أيّام العادة والاستظهار عن العشرة، تختصّ بمن كانت عادتها ثمانية فما دون، فيكون أخصّ مطلقاً من أخبار الواحد، لأنّها فيمن كانت عادتها تسعاً فما دون، فيقع التعارض حينئذٍ بين أخبار الاثنين والانتظار الى العشرة، وأخبار الاثنين أيضاً مخصّصة بأخبار الثلاثة، لأنّ أخبار الثلاثة مختصّة بمن كانت عادتها سبعاً فما دون بالتقريب المتقدّم، وأخبار الثلاثة أيضاً مخصّصة باخبار ثلثي العادة، لأنّها فيمن كانت عادتها ستاً فما دون، فيقع التعارض بين أخبار الثلثين والانتظار الى العشرة.
ويمكن أن يقال: إن أخبار الثلثين مختصّة بمن كانت عادتها ستاً، لأنّ إرادة ما دون الست منها موقوف على ملاحظة الكسور في عدد الأيّام، وهو بعيد، مع أنّه لو قلنا بعمومها لما دون الست يمكن أن يقال: إنّ اطلاق الحكم بالثلثين لندرة استقرار العادة على ما دون الست.
قلت: لا يخفى بعد هذا التوجيه في الأخبار، لأنّه مستلزم لتخصيص الأكثر في كثير من الأخبار، مع أنّه انّما يصح إذا قلنا بجواز ملاحظة النسبة بين المتعارضين بعد تخصيص أحدهما بمنفصل، كما هو خيرة بعض الاصوليين، لأنّ أخصيّة أخبار الاثنين عن الواحد انّما هو بعد تقييدها بما دلّ على أنّ أكثر الحيض عشرة، وهو خلاف التحقيق.
ويرد على الوجهين: بأنّ جعل اليوم أو اليومين والثلاثة في الأخبار المعيّنة لها على المثال، بعيد جدّاً.
ودعوى أنّ مادّة الاستظهار قرينة على اختصاصها بمن يظهر لها الحال بذلك العدد المعيّن.
مدفوعة: أوّلاً: بأنّ الاستظهار أعمّ من ظهور الحال.
والقول: بأنّ حقيقة الاستظهار هو الطلب المرتّب عليه الظهور.
مدفوع بالمنع من ذلك، إذ لا شهادة على ذلك من اللغة وغيرها، مع أنّ كون المراد من الاستظهار هو معناه اللغوي ممنوع، بل المراد هو الاحتياط، ومن ذلك قولهم أمر خرّاصو النخل بأن يستظهروا لأربابها أي يحتاطوا لهم في سهامهم من الثمن، ولعلّه يظهر للتأمّل في الأخبار ما يشهد لذلك: ويحتمل قريباً أن يراد من أوامر الاستظهار الاستحباب، ويكون الاختلاف باختلاف مراتب الاستحباب.
وممّا يشهد لذلك صحيحة محمّد بن مسلم سألت أبا جعفرعليهالسلام عن النفساء كم تقعد؟ قال: إنّ أسماء بنت عميس نفست فأمرها رسول اللّهصلىاللهعليهوآله : أن تغتسل لثمانية عشر يوماً، ولا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين(١) . بناءً على أنّ حكاية الأسماء(٢) إعراض عن الجواب بوجه حسن تقيّةً، ويكون المراد هو الاستظهار بعد أيّام العادة.
وممّا يشهد لذلك أخبار التخيير بين الاعداد، فانّ الحمل على الاستحباب وكون التخيير بملاحظة مراتب الاستحباب، أولى من حملها على التنويع بملاحظة عادة المرأة، أو على المثال وإرادة بيان ما يظهر به الحال.
فإن قلت: لا داعي لصرف أوامر الاستظهار عن ظاهرها من الوجوب، خصوصاً مع إباء كثير من الأخبار عن ذلك، مثل موثقة مالك بن أعين(٣) الدالّة بمفهوم نفي البأس المعلّق على مضيّ يوم الاستظهار على حرمة الوطء قبله. ومثل صحيحة زرارة: المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها، وتحتاط بيوم أو اثنين، ثمّ تغتسل كلّ يوم وليلة ثلاث مرّات - إلى أن [ قال: ] - فإذا حلّ لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها(٤) . فانّ ظاهرها أن الوطء في أيّام الاستظهار حرام. ومثل موثّقة
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب أن أكثر النفاس عشرة، من أبواب النفاس، ح ١٥، ج ٢، ص ٦١٥.
(٢) في النسختين هكذا والصحيح أسماء.
(٣) وسائل الشيعة: ب أن أكثر النفاس عشرة، من أبواب النفاس، ح ٤، ج ٢، ص ٦١٢.
(٤) وسائل الشيعة: ب الاستحاضة أقسامها وجمله من أحكامها، ح ١٢، ج ٢، ص ٦٠٨.
يونس(١) فانّ الأمر بالاستظهار في جواب قول السائل عن التي تجاوز دمها أيّامها « متى ينبغي » دليل على أنّه قبل مضيّ أيّام الاستظهار لا يجوز العبادة، هذا مع أنّ الحمل المذكور، مستلزم للخروج عن ظاهر أخبار الطرفين بلا شاهد، بل لمعارض أن يعارضه بالعكس فيحمل أخبار المبادرة الى الغسل بعد تجاوز العادة على الاستحباب. وأيضاً الحمل على الاستحباب، وحمل الأختلاف في الأخبار على اختلاف مراتب الاستحباب، مستلزم لمخالفة الظاهر من وجه آخر فانّ ظاهر كلّ واحد من الأخبار وجوب عمل المستحاضة بعد مضي ما عيّنه للاستظهار، ومقتضى الحمل المذكور مخالفة هذا الظاهر في كثير منها بل أكثرها.
قلت: اختلاف الأخبار على وجه لا يكاد يمكن الجمع بينها شاهد، مضافاً إلى ما مرّ من صحيحة محمد بن مسلم(٢) ومناسبة الاحتياط والانتظار والاستظهار للاستحباب معيّن لصرف الأمر عن ظاهره. وأمّا نفي البأس في موثقة مالك يدلّ على ثبوت البأس في أيّام الاستظهار، وليس هو بأظهر من أوامر الاستظهار في الدلالة على حرمة الوطئ في يوم الاستظهار.
وأمّا قوله: « فإذا حلّ لها الصلاة » في صحيحة زرارة(٣) انّما يدلّ على ملازمة حلّ الوطء لحلّ الصلاة، وأما كون حلّ الصلاة بعد الاستظهار فموكول إلى ظاهر الأمر بالاستظهار، وليس في ذلك دلالة على أنّه بعد الاستظهار.
وامّا قول السائل في موثّقة يونس « متى ينبغي » فليس فيه ظهور تام في السؤال عن زمان جواز الصلاة، بل لعلّ ظاهره متى يحسن لها الصلاة، ومقتضى الجواب أنّه لا يحسن لها الصلاة قبل الاستظهار، وهو أعمّ من وجوب الاستظهار.
وأمّا استلزام مخالفة الظاهر في أخبار الطرفين فمدفوع بأنّ الأخبار التي عدّ
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب أستحباب أستظهار ذات العادة، من أبواب الحيض، ح ١٥، ج ٢ ، ص ٦١٥.
(٢) وسائل الشيعة: ب أن أكثر النفاس عشرة أيّام، من أبواب النفاس، ح ١٢، ج ٢، ص ٦٠٨.
(٣) وسائل الشيعة: ب اقسام ابواب الاستحاضة، ح ١٢، ج ٢، ص ٥٥٨.
ظاهرها منافياً للاستظهار كثير، منها لا ينافي ذلك، وأمّا المنافي له منها فلا محيص عن مخالفة الظاهر فيه،إمّا بحملها على الجواز، أو بوجه آخر من الوجوه المتقدّمة.
وأمّا المعارضة فمدفوعة، بأنّ حمل أوامر الاستظهار على الاستحباب لمناسبة لفظ الاحتياط، والانتظار، أولى من العكس.
وأمّا استلزام الحمل المذكور لمخالفة الظاهر من وجه آخر، فلا ضير فيه بعد وجود الشاهد والقرائن التي يطّلع عليها المتأمّل في الأخبار. فالقول باستحباب الاستظهار وفاقاً لعامّة المتأخّرين لا يخلو عن قوّة، وإن كان الأحوط ما عليه كثير من القدماء، وجملة من متأخّري المتأخرين، فينبغي مراعاته خصوصاً بالنسبة إلى تروك الحائض.
بقي هنا شيء ينبغي التنبيه عليه، وهو أنّ مقتضى القول باستحباب الإستظهار جواز العبادة في أيّامه وصحّتها لو انكشف كون الدم استحاضة بتجاوزه عن العشرة. وذلك يقتضي الأمر بالعبادة حال الشكّ في كون الدم استحاضة، إذ لا يكفي في صحّة العبادة وجوازها، وجود الأمر الواقعي إذا لم يكن طريق إليه كما هو المفروض.
ولا ريب أنّ الأمر الظاهري بالعبادة وجوباً أو استحباباً ينافي استحباب الاستظهار.
ويمكن الجواب عن ذلك:
أوّلاً: بأنّ معنى الاستظهار هو البناء على كون الدم في أيّام الإستظهار حيضاً، نظير تخيير المبتدئة في التحيّض بالستّ والسبع، فالإستحباب يتعلّق باختيار التحيّض، وذلك لا ينافي الأمر بالعبادة إذا اختارت عدم كون الدم حيضاً. وبذلك يندفع أيضاً إشكال التخيير بين الأقلّ والأكثر في الإستحباب، مع عدم كون الأكثر أفضل الأفراد، كما هو المحكي عن الشهيد(١) . ولكنّ الإنصاف أنّ هذا مخالف لظاهر الأخبار وفتاوى الأصحاب.
____________________
(١) ذكرى الشيعة: مبحث الحيض، ص ٢٩، س ٢٦.
وثانياً: بأنّ معنى جواز العبادة، جواز الاحتياط في فعلها، باحتمال كون الدم إستحاضة، وذلك يكفي في صحّة العبادة لو انكشف وجود الأمر واقعاً، وفي جوازها ظاهراً، إذ يكفي في خروج العبادة عن التشريع القصد إليها لإصابة الأمر الواقعي المحتمل.
بل يمكن أن يقال: بناءً على وجوب الإستظهار بصحّة العبادة لو أتى بها لإصابة الأمر المحتمل، إلاّ أن تأتي قصد الإمتثال بالنسبة، إليه، مع كون العبادة مخالفة معلومة للأمر الظاهر بتركها مشكل، وصدق الإطاعة التي هي المقصد الأصلي من العبادات عليها على فرض إمكان القصد أشكل.
فإن قلت: إذا قلنا بحرمة العبادة على الحائض ذاتاً، كان معنى استحباب الإستظهار، استحباب ترك العبادة، لإحتمال كونها في الواقع محرمة، وأمّا بناءً على ما هو التحقيق من حرمتها عليه تشريعاً فما معنى إستحباب الاستظهار.
قلت: المستحب هو التشبّه بالحائض في الأفعال والتروك.
قولهقدسسره : « فإن استمرّ الى العاشر وانقطع قضت ما فعلته من صوم ».
أقول: المشهور بين المتأخّرين أنّ أيّام الإستظهار وما بعدها إذا انقطع الدم على العشرة حيض. وعن الحدائق: أنّه ظاهر الأصحاب(١) . بل عن ظاهر بعض وصريح التذكرة الإجماع عليه(٢) ، بل هو داخل في معقد إجماع الخلاف(٣) .
____________________
(١) الحدائق الناضرة: ج ٣، ب أستظهار ذات العادة، ص ٢١٦، س ٩.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١، كتاب الطهارة، أحكام الحيض، ص ٢٩، س ٩.
(٣) كتاب الخلاف: ج ١، كتاب الحيض، ص ٦٥، س ٢.
والمعتبر(١) والمنتهى(٢) والنهاية(٣) على أنّ ما تراه من الثلاثة إلى العشرة إذا انقطع عليها حيض، وذلك بناءً على إنتهاء أيّام الإستظهار إلى العاشر واضح، إذ المقصود من الإستظهار ظهور حال الدم بالإنقطاع وعدمه، وأمّا بناءً على عدم إنتهائها إليه فيدلّ عليه زيادة على ما مرّ أصالة بقاء الحيض وأحكامه.
قلت: التمسّك بأصالة بقاء الدم بالنسبة إلى وجوب الغسل عند الإنقطاع حسن، ولكن لا يثبت بها قضاء الصوم، لأنّه فرع صدق الفوت. وكذلك الكلام في أصالة بقاء الأحكام إن صحّ التمسّك بها، فانّ من أحكام الحائض وجوب الغسل عليها إذا انقطع الدم.
ويدلّ عليه أيضاً قاعدة الإمكان.
وقد يتمسّك أيضاً بروايتي محمد بن مسلم المتقدّمتين(٤) وأخبار الاستبراء(٥) . وفي التمسّك بهما نظر يظهر وجهه ممّا تقدّم. مضافاً إلى أنّ أخبار الاستبراء تقتضي وجوب التحيّض إذا خرجت القطنة ملوّثة.
ولا ريب أنّ الدم ما لم يعلم إنقطاعه على العشرة يعمل معه معاملة الاستحاضة، بناءً على إنتهاء أيّام الإستظهار إلى العشرة، فكيف يتمسّك بها لكون الدم المنقطع على العشرة حيضاً؟
وكيف كان فلا ينبغي التأمّل في المسألة، إلاّ أنّ المحكي عن أصحاب المدارك(٦) ، والمفاتيح(٧) والحدائق(٨) الإشكال فيها، نظراً إلى ما دلّ على أنّ ما بعد
____________________
(١) المعتبر في شرح المختصر: ج ١ كتاب الطهارة، في الحيض، ص ٥٧، س ١٢.
(٢) المنتهى: كتاب الطهارة، في أحكام الحيض وما يتعلق به، ص ١١٣، س ٧.
(٣) النهاية: كتاب الطهارة، ب حكم الحائض والمستحاضة، ص ٢٦، س ٤.
(٤) وسائل الشيعة: ب أن أكثر النفاس عشرة، من أبواب النفاس، ح ١٤، ج ٢، ص ٦١٤، وح ١٥، أيضاً ص ٦١٥.
(٥) وسائل الشيعة: ب وجوب أستبراء الحائض، من أبواب الحيض، ج ٢، ص ٥٦٢، انظر الباب.
(٦) مدارك الأحكام: ص ٦٣، س ٣٠.
(٧) مفاتيح الشرائع: أحكام الحيض، ج ١، ص ١٥.
(٨) الحدائق: أستظهار ذات العادة، ج ٣، ص ٢٢٣.
أيّام الإستظهار استحاضة.
ويمكن أن يقال: أنّ المراد بكونه استحاضة، أنّه يجب أن يعمل عملها، كما يشهد بذلك قولهعليهالسلام في موثّقة سماعة: فإذا تربّصت ثلاثة أيّام ولم ينقطع عنها الدم فلتصنع كما تصنع المستحاضة(١) .
إلاّ أن يقال: إنّ ذلك بيان للموضوع بإثبات حكمه.
وقولهعليهالسلام في بعض الروايات: فلتغتسل، أو فلتصل(٢) . ولا منافاة بين أن تعمل عمل المستحاضة، وبين أن يحكم بعد انكشاف الخلاف بكونها حيضاً.
فإن قلت: كون المراد من أخبار الإستظهار وجوب عمل المستحاضة بعده ينافي قاعدة الإمكان، لأنّها جارية قبل العلم بالتجاوز أيضاً، فأمّا أن يرفع اليد عن تلك الأخبار ويؤخذ بالقاعدة، أو العكس، ولا وجه للجمع بينهما.
قلت: هذا غلط، فانّ عدم التمسّك بالقاعدة في الدم المشكوك انقطاعه على العشرة لمعارض، أو لعدم جريانها، لا ينافي التمسّك بها في الدم المنقطع، وكذا الكلام بالنسبة الى أصالة بقاء الدم.
فإن قلت: إطلاق الأمر بالغسل يشمل صورة العلم بالإنقطاع، وذلك ينافي الحكم على المنقطع بالحيضية.
قلت: إطلاق الأمر لكونه في مورد الشكّ في كون الدم حيضاً تابع لبقاء الشكّ، فلا يشمل صورة وجود العلم برافع الشك، فافهم. ولتحقيقه مقام آخر.
وقد يجاب أيضاً: بأنّ المستحاضة ليس لها حقيقة شرعية، ومعناها العرفي إن كان مطلق من استمرّ دمها بعد أيّام العادة كما عن الصحاح(٣) ، كانت المرأة مستحاضة قبل الاستظهار بمجرّد انقضاء العادة، وهذا المعنى يجامع الحيض، كما إذا
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم ح ١، ج ٢، ص ٥٥٦.
(٢) وسائل الشيعة : ب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة وكيفيته، ح ١، ج ٢، ص ٥٦٢.
(٣) صحاح اللغة: ج ٣، ص ١٠٧٣.
انقطع الدم في أيّام الاستظهار وإن كان معناها التي استمرّ دمها أشهر أو سنين، فلا مناص عن حمل ما دلّ على كونها مستحاضة بعد الاستظهار على أنّها بمنزلتها، لكنّ الظاهر من هذا التنزيل المسوق لبيان حكم المرأة في العمل في الحال، كونها بمنزلتها في وجوب العبادة، أما إجزاء ما فعلت بعد الانقطاع على العشرة فهو حكم آخر، ليس في الأخبار دلالة على ثبوته ونفيه، مع أنّه لو سلّم التعارض فالنسبة عموم من وجه، فالمرجع أصالة بقاء الحيض وأحكامه، فتأمّل. إنتهى.
أقول: المستحاضة: هي ذات دم خاص يجري من عرق غير عرق الحيض، وعدم العلم بها إلاّ بمميّز شرعي لا يصرف اللفظ عن معناه، ولو سلّم أنّ معناها العرفي أحد الأمرين اللذين ذكرهما المجيب، فالمتتبّع في الأخبار يشهد، بأنّ المراد من المستحاضة في أمثال هذه المقامات هو ما ذكرناه فتأمّل.
وأمّا ما ذكر من أنّ النسبة عموم من وجه، يرد عليه أنّ أخبار الإستظهار حاكمة على قاعدة الإمكان، إذ مفادها حينئذٍ جعل التجاوز عن أيّام الإستظهار أمارة كون الدم استحاضة، كما أنّ التجاوز عن العشرة أمارة ذلك عند المشهور، إلاّ أن يقال: إنّ كلام المجيب مبني على أنّ الاستحاضة ليس دم خاص يجعل له أمارة، مع أنّ الإرجاع بعد التساقط الى ما مرّ من الأصل في إثبات القضاء قد عرفت الإشكال فيه سابقاً، بل الظاهر هو الرجوع إلى أصالة البراءة، ولعلّه لذلك أمررحمهالله بالتأمّل، فتأمّل.
وقد يعارض ما ذكر بذيل المرسلة القصيرة(١) ، وأخبار الصفرة(٢) ، ويظهر من بعض ما تلونا عليك الجواب عنها، ومع التعارض فالترجيح مع القاعدة والاجماعات
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب، ان الصفرة والكدرة في ايام الحيض حيض وفي ايام الطهر طهر، ح ٣، ج ٢، ٥٤٠.
(٢) وسائل الشيعة: ب ان الصفرة والكدرة في ايام الحيض حيض وفي ايام الطهر طهر، انظر الباب، ج ٢ ص ٥٣٩ - ٥٤١.
السابقة كما لا يخفى.
قولهقدسسره : « وإن تجاوز كان ما أتت به مجزياً ».
أقول: إذا تجاوز الدم عن العشرة، كان ما زاد على العادة استحاضة كلّه، فيكون ما أتت به بعد الإستظهار مجزياً، وتقضي ما اختلّت به من العبادة في أيّام الإستظهار. والظاهر عدم الخلاف إلاّ ما يظهر من صاحب المدراك(١) ، حيث توقّف في ذلك. وسيأتي لذلك مزيد إن شاء اللّه تعالى.
قولهقدسسره : « الرابعة: إذا طهرت جاز لزوجها وطئها قبل الغسل على كراهية ».
أقول: المشهور كراهة وطء الطاهرة من الحيض قبل الغسل، بل عن جماعة الإجماع عليه.
وعن الفقيه أنّه حرام(٢) ، وعبارته المنقولة عنه لا تعطي ذلك كما قبل.
ويدلّ عليه أصالة الإباحة السليمة عن مزاحمة استصحاب الحرمة، لأنّها منوطة بأيّام الحيض، أو بالحائض، وهو مرتفع بعد النقاء.
ودعوى أنّ الحيض موجب للحكم، لا قيد للموضوع، كما أنّ الزمان أيضاً ظرف له.
مدفوعة بأنّ الظاهر أنّ الحيض داخل في الموضوع، كما هو مقتضى ظاهر
____________________
(١) المدارك: ب في الحيض، ص ٤٩، س ٢٩.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ١، غسل الحيض والنفاس، ص ٩٥.
الأدلّة، وقوله تعالى: (ولا تقربوهنّ حتى يطهرن)(١) بقراءة التخفيف. والظاهر من الطهر مقابل الحيض، كما يشهد به تتّبع موارد استعماله في مقابل الحيض في الأخبار التي لا تحصى، مع أنّه معتضد لظاهر قوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض)(٢) ، نظراً إلى ظهور العطف في التفسير والتأكيد.
وممّا يؤكد ذلك: تعليل الأمر بالاعتزال بكونه أذىً أي موذياً، لقذارته كما حكي عن أهل تفسير(٣) . ولا ريب أنّ هذه العلّة لا تقتضي الحرمة بعد النقاء، إذ المحيض الذي حكم عليه بأنّه أذى، إما اسم للدم، أو مصدر ميميّ من حاض المرأة: إذا سال دمها.
ودعوى الحقيقة الشرعية ليطهرن في التطهّر، ممنوعة، وإن سلّمنا أنّ الطهارة اسم للأفعال الثلاثة شرعاً.
نعم يعارض هذه القراءة بقراءة التشديد.
وأجاب عنه المصنّف في المعتبر(٤) كما حكي: بوجوب الجمع بين القراءتين بحمل الأمر في قراءة التشديد على الكراهة.
وأجاب غيره: بأنّ التطهّر بمعنى الطهر، وأنّ تفعّل يجيء بمعنى فعل كتطعّم، وتبسّم، وتبيّن، بمعنى طعم، وبسم، وبان.
أقول: ويمكن الجمع بوجه آخر: وهو أن يجعل التطهّر كناية عن الطاهر، كما يجعل الأذان كناية عن دخول الوقت لغلبة وقوعه عنده.
وأورد عليه: بأنّ الجمع فرع ثبوت تواتر كلّ من القراءتين، بناءً على تواتر القراءات السبع، أو ثبوت الإجماع على جواز العمل بكلّ من القراءات، كما جاز القراءة بكلّ منهما.
____________________
(١) البقرة: ٢٢٢.
(٢) البقرة: ٢٢٢.
(٣) مجمع البيان: ج ١، في تفسير الآية « ٢٢٢ »، ص ٢١٣، س ٣.
(٤) المعتبر: كتاب الطهارة، في المحيض، ص ٦٢، س ٢٧.
وكلا الأمرين في محلّ المنع، مع أنّ حمل الطهر على الحالة الحاصلة عقيب الغسل أولى من حمل التطهّر على الطهر من الحيض، مع أنّ حمل قراءة التشديد على الكراهة لا يخلو من استعمال اللفظ في المعنيين، لأنّ تعدّد القراءة في يطهرن لا يوجب تعدّد الاستعمال في (لا تقربوهنّ)(١) .
قلت: تصوّر تعدّد القراءة في « تطهران » مع وحدة الاستعمال في « لا تقربوهنّ » لا يخلو عن صعوبة، مع أنّه يكفي في رفع المعارضة إحتمال التعدّد، لأنّ الإلجاء إلى إرجاع التطهّر إلى الطهر، أو العكس، انّما هو عند وحدة الاستعمال في (لا تقربوهنّ)، لئلاّ يلزم نسبة فعل واحد الى غايتين مختلفتين في استعمال واحد، فانّه أشبه شيء باستعمال لفظ واحد في معنيين، إذ على فرض تعدّد الاستعمال يصحّ إبقاء كل من الظاهرين على حاله، وحمل النهي في أحدهما على الكراهة.
والحاصل: أنّه بناءً على تعدّد الاستعمال في (لا تقربوهنّ) يدور الأمر في رفع المعارضة، بين حمل النهي على الكراهة، أو حمل الطهر على الحاصلة عقيب الغسل، ولا ريب أنّ الأوّل أولى مع وحدة الاستعمال في (لا تقربوهن)، لا محيص عن حمل الطهر على الحالة الحاصلة، لأنّ إرجاع التطهّر الى الطهر بعيد، فمع الشكّ في تعددّ الاستعمال لا يعلم صارف عن ظاهر (يطهرن) بالتخفيف، إذ الفرض أنّ كون « يطهرن » بالتشديد صارفاً مبنيّ على وحدة الاستعمال، وهو غير معلوم، فتأمّل.
هذا كلّه مع البناء على أحد الأمرين من تواتر القراءات، أو الإجماع على جواز العمل بكل منهما، ومع عدمه فالتحقيق سقوط الاستدلال بالآية، إذ اللفظ المنزّل حينئذٍ مردّد بين التشديد والتخفيف، فلا يعارض بها الفقرة اللاحقة، وهي قوله تعالى: (فإذا تطهّرن)(٢) بناءً على ظهوره في توقّف الجواز على الاغتسال، لظهور التطهّر في الغسل دون الوضوء، ودون غسل الفرج.
نعم يعارض بها إن ثبت أحد الأمرين، ورجّحنا قراءة التخفيف على التشديد،
____________________
(١ و ٢) البقرة ٢٢٢.
فيتعيّن صرف الطهر إلى الحالة الحاصلة عقيب الغسل، لأنّه أقرب من حمل التطهّر الى غير الغسل من الوضوء وغسل الفرج، فتأمّل.
إلا أن يقال: انّ قوله تعالى: (فاعتزلوا النساء)(١) خصوصاً بملاحظة التعليل كما مرّ، يقتضي التصرّف في التطهّر بل هو نفسه معارض لقوله تعالى: (فإذا تطهّرن) ولو قيل : إنّ التطهّر كناية عن الطهر كان وجهاً للجمع.
ثم إنّه يمكن أن يقال: إنّ قوله تعالى: (فإذا تطهّرن) لسوقه في مقام بيان مفهوم قوله (حتى يطهرن)، خصوصاً بملاحظة التفريع ليس له مفهوم، فدلالته على توقّف الحلّ على الاغتسال إن كانت، فانّما هي لظهور المقام في كونه تمام المفهوم، ورفع اليد عن هذا الظهور لا يبعد أن يكون أولى من التصرّف في « يطهرن » بالتخفيف.
ومن هنا عرفت: أنّ التعارض بين ظهور (حتى يطهرن) وبين ظهور قوله تعالى (فإذا تطهّرن) ليس من تعارض المفهومين.
وكيف كان فلا تخلو الآية عن الإشارة إلى الغسل، وإن لم يبلغ حدّ الاستدلال، ولكن في الإجماعات والأصل غنىً عن ذلك، مضافاً إلى أخبار كثيرة.
كموثقة ابن بكير: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء(٢) .
ومرسلة ابن المغيرة: المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمسّ الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل، وإن فعل فلا بأس، وتمسّ الماء أحبّ إليّ(٣) .
وموثّقة ابن يقطين: عن الحائض ترى الطهر أيقع عليها زوجها قبل ان تغتسل؟ قالعليهالسلام : لا بأس، وبعد الغسل أحبّ إليّ(٤) .
وأمّا موثّقة أبي بصير: عن امرأة كانت طامثاً فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل
____________________
(١) البقرة: ٢٢٢.
(٢) وسائل الشيعة: ب جواز الوطئ بعد انقطاع الحيض، من أبواب الحيض، ح ٣، ج ٢، ص ٥٧٣.
(٣) وسائل الشيعة: ب جواز الوطئ بعد انقطاع الحيض، من أبواب الحيض، ح ٤، ج ٢، ص ٥٧٣.
(٤) وسائل الشيعة: ب جواز الوطئ بعد انقطاع الحيض، من أبواب الحيض، ح ٥، ج ٢، ص ٥٧٣.
أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل(١) . وموثقة سعيد بن يسار: المرأة تحرم عليها الصلاة ثمّ تطهر فتتوضّأ قبل أن تغتسل، أفلزوجها أن يأتي قبل أن تغتسل؟ قالعليهالسلام : لا حتى تغتسل(٢) . محمولتان على الكراهة، أو التقية لصراحة الأخبار السابقة في الجواز.
وأمّا صحيحة ابن مسلم: إن أصاب زوجها شبق، فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل(٣) فليس فيها شهادة على الجمع بين أخبار المنع مطلقاً والجواز كذلك بحمل الاولى على غير من أصابه شبق، والثانية على من به شبق، لإحتمال أن يكون التفصيل من حيث الكراهة.
ويشهد لذلك: رواية إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا ابراهيمعليهالسلام عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله؟ فقالعليهالسلام : ما أحبّ أن يفعل ذلك إلاّ أن يكون شبقاً، أو يخاف على نفسه(٤) .
ثمّ إنّ المحكي عن ظاهر الأكثر اشتراط الجواز بغسل الفرج. وعن الجامع(٥) : اشتراطه بالغسل ووضوء الصلاة. وعن ظاهر التبيان(٦) ، وأحكام الراوندي(٧) ، ومجمع البيان(٨) : إشتراط أحدهما، بل عن الأخير(٩) : أنّه مذهبنا، وليس في الأدلّة ما يشهد لوجوب الوضوء، إلاّ أن يحمل الطهر في الآية على ذلك، وفيه بعد.
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب جواز الوطئ بعد أنقطاع الحيض، من أبواب الحيض، ح ٦، ج ٢، ص ٥٧٣.
(٢) وسائل الشيعة: ب جواز الوطئ بعد انقطاع الحيض، من أبواب الحيض، ح ٧، ج ٢، ص ٥٧٤.
(٣) وسائل الشيعة: ب جواز الوطئ بعد انقطاع الحيض، من أبواب الحيض، ح ١، ج ٢، ص ٥٧٢.
(٤) وسائل الشيعة: ب جواز الوطئ بعد انقطاع الحيض، من أبواب الحيض، ح ٢، ج ٢، ص ٥٧٣.
(٥) الجامع للشرائع: ص ٤٣ في الطهارة.
(٦) التبيان: ج ٢، ص ٢٢٠، س ١٥.
(٧) المصدر غير موجود بأيدينا.
(٨) مجمع البيان: ص ٢١٤، س ١١ ج ١.
(٩) مجمع البيان: ص ٢١٤، س ١١ ج ١.
ولكن ثبوت الاستحباب بفتوى الجماعة، مضافاً إلى ظهور الإجماع المحكي عن مجمع البيان(١) في ثبوته في الجملة.(٢) وأمّا غسل الفرج فمقتضى إطلاق موثقه ابن بكير عدم وجوبه، وظاهر صحيحة ابن مسلم وجوبه، من حيث إنّ ظاهر الأمر بالأمر هو الوجوب، وهو يقتضي توقّف جواز المسّ على أمرها بالغسل، ولازمه التوقّف على الغسل، لبداهة أنّ الأمر لا دخل له في ذلك، إلاّ من حيث التوصّل إلى الغسل.
ويمكن منع الظهور، نظراً إلى ما عرفت من قوّة كون الصحيحة في مقام التفصيل من حيث الكراهة، فانّ مفادها حينئذ أنّها إن اغتسلت وكان بالزوج شبق أباح له الوطء، وذلك لا يقتضي توقّف الجواز بالمعنى الأعم على الغسل، وذلك واضح.
ومن ذلك يظهر الجواب عن الاستدلال للوجوب برواية أبي عبيدة في فاقدة الماء إذا غسلت فرجها وتيمّمت فلا بأس(٣) . فانّ مفهومها ثبوت البأس مع انتفاء أحد الأمرين، توضيحه: أنّ البأس الثابت على تقدير إنتفاء التيمّم هو الكراهة قطعاً، بناءً على توقّف الجواز على غسل الحيض، ومعه لا يمكن إرادة ثبوت الحرمة مع غسل الفرج، غاية الأمر أنّ الرواية لا تدلّ على نفي الحرمة على تقدير عدم الغسل، لأنّ البأس المنفي على تقدير وجود الشرطين، أعمّ من الوجوب والكراهة.
ودعوى أنّ ظاهر الرواية هو الحرمة بدون تحقّق الأمرين، وعدم إمكان العمل بظاهرها في بعض مدلولها، نظراً إلى المعارض لا يقتضي ترك العمل بها في البعض الآخر.
مدفوعة بأنّ الجمع بين الأخبار بحمل ظاهرها على أظهرها، يقتضي إرادة الكراهة من البأس المنفي أو الأعم، لا خصوص الحرمة.
والحاصل: أنّ إثبات الوجوب المنفي بالأصل بالروايتين، خصوصاً مع قوّة
____________________
(١) مجمع البيان: ص ٢١٤، س ١١ ج ١.
(٢) كذا في النسخة والعبارة غير تامّة.
(٣) وسائل الشيعة: ب جواز الوطء الحائض عند الأنقطاع وتعذر الغسل، من أبواب الحيض، ح ١، ج ٢، ص ٥٦٤.
إطلاقات الجواز، لكونها في مقام البيان مشكل.
فالأقوى استحباب غسل الفرج بمعنى كراهة الوطء أو شدّتها بدونه.
ثمّ على القولين من زوال التحريم، أو الكراهة بالغسل، ففي مشروعيته بمجرّد ذلك إشكال، من حيث إنّ ظاهر ما دلّ على توقّف الإباحة، أو الجواز على الغسل عدم تحقّقهما بدونه، وأمّا أنّ الغسل لإباحة الوطء أو جوازه مشروع فلا دلالة فيه عليه، بل الظاهر منهما أنّ التوقّف عليه، هو الغسل الرافع لحدث الحيض، وأنّ الموجب للكراهة أو الحرمة هو بقاء الحدث.
والحاصل: أنّ إثبات مشروعية غسل خاص فائدته، إباحة الوطء أو جوازه، دون رفع الحدث بهذه الأخبار مشكل، بل الظاهر خلافه، لأنّ ظاهرها كون الموجب للحرمة أو الكراهة هو حدث الحيض، وأنّ المتوقّف عليه رفعهما هو الغسل الرافع للحدث، لإنصرافه قوله « حتى تغتسل » أو « قبل أن تغتسل » الى ذلك.
ثمّ إن قلنا: بأنّ الموقوف عليه هو الغسل الرافع، ففي صحّته قبل وجوب ما يتوقّف عليه، من الصلاة أو الصوم إشكال، من حيث إنّ حرمة الوطء بدون الغسل، لا يستلزم الأمر به.
إلا أن يقال: إنّ المستفاد من الأخبار نظراً إلى أنّ الظاهر منها عدم تضيّق الأمر على الزوج وتمكّنه من المسّ متى شاء، مشروعية الغسل لرفع الحدث في نفسه، وأنّه أمر راجح لها متمكّنة منها متى شاءت، أو أنّ حرمة الوطء، أو الكراهة بدون الغسل مع وجوب تسليمها، يستلزم وجوب الغسل، أو إستحبابه إذا طلب منها الزوج التسليم فتأمّل.
ثمّ إن فقدت الماء فهل يشرع لها التيمّم بدلاً؟ ففي زوال التحريم أو الكراهة إشكال، من عموم البدلية ورواية أبي عبيدة السابقة(١) ، وموثقة عمّار عن أبي عبد اللّهعليهالسلام : عن المرأة إذا تيمّمت من الحيض هل يحلّ لزوجها ؟ قال:
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب جواز الوطئ الحائض عند الأنقطاع، من أبواب الحيض، ح ١، ج ٢، ص ٥٦٤.
نعم(١) ، ومن أنّ الحكم منوط بالاغتسال، وعموم البدلية أنّما يراد به البدلية من حيث الأحكام المنوطة بالطهارة، ورفع الحدث، لا خصوص بعض الوضوءات أو الأغسال، والروايتان ضعيفتان.
والتحقيق أن يقال: انّ الحرمة والكراهة، إن كان مناطهما الحدث كما هو الأقوى كان التيمّم مؤثّراً في رفع الحرمة، وكذلك في زوال الكراهة، إلاّ أنّ بعض الأخبار تقتضي بقاءهما معه أيضاً، كموثّقة البصري عن امرأة حاضت ثمّ طهرت في سفر، فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة، هل لزوجها أن يقع عليها؟ قال: لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل(٢) . فانّ إطلاقها يقتضي الحرمة أو الكراهة مع التيمّم أيضاً.
ويمكن الجمع بناءً على الحرمة بين هذه والروايتين السابقتين بتقييد هذه بهما، إلاّ أن فيه بعداً، من حيث إنّ مورد هذه هو صورة تعذّر الماء.
ويمكن أن يقال: على الكراهة بأنّها تخفّف بالتيمّم، وإن كان مناطهما الغسل بما هو على أضعف الوجهين لم يؤثّر التيمّم لتعارض الروايات وبعد الجمع كما عرفت، وانتفاء عموم البدلية، ثمّ إنّ في مشروعية التيمّم بناءً على زوال التحريم به لمحض إباحة الوطء أو جوازه إشكال.
ويمكن أن يقال: انّ التيمّم يجب عند فقد الماء في موضع وجب الغسل مع وجوده، لأنّ مقتضى عموم البدلية ووجوب ما يتوقّف عليه التيمّم هو ذلك، وأمّا استحبابه في موضع يستحبّ الغسل، ففيه إشكال من عدم الدليل على بدلية التيمّم عن الغسل والوضوء إذا لم يتّصفا بالوجوب، وإن كانا رافعين للحدث.
واعلم أنّ أغلب هذه المباحث محتاج إلى مزيد تأمّل، إلاّ أنّ للتحقيق فيها محلاً آخر.
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب جواز وطء الحائض عند الانقطاع، من أبواب الحيض، ح ٢، ج ٢، ص ٥٦٥.
(٢) وسائل الشيعة: ب جواز وطء الحائض عند الانقطاع، من أبواب الحيض، ح ٣، ج ٢، ص ٥٦٥.
ثمّ إن قلنا ببدلية التيمّم وفقد التراب، فالأقرب تحريم الوطء، لعموم أدلّة التوقّف، ويحتمل انصرافها إلى صورة التمكّن.
قولهقدسسره : إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة، وجب عليها القضاء ».
أقول: لا إشكال في أنّه إذا دخل الوقت فحاضت، وقد مضى مقدار الطهارة المائية، والصلاة الاختيارية، من حيث سائر الشرائط والأجزاء، ويمكن من كلّ منهما، وجب عليها قضاء الصلاة، سواء كانت عالمة بطرو الحيض وتركت الصلاة، أو أخّرتها مع الجهل به، وإن كان الحيض بعد مضي مقدار الطهارة الترابية، والصلاة الاختيارية من جهة سائر الشرائط والأجزاء، أو مقدار الطهارة كذلك والصلاة الاضطرارية، أو مقدار الطهارة المائية والصلاة الاضطرارية، ففي وجوب القضاء إشكال، وظاهر عبارة المصنّف حيث أطلق الطهارة والصلاة، وجوب القضاء في جميع هذه الصور، إلاّ أن يدّعى انصراف الطهارة إلى المائية، والصلاة إلى الاختيارية، وليس ذلك بكل البعيد.
وكيف كان فيدلّ على الحكم في الصورة الاولى قبل الإجماع وموثّقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّهعليهالسلام قال: في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فأخّرت الصلاة حتى حاضت، قالعليهالسلام : تقضي إذا طهرت(١) .
ورواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن امرأة طمثت بعد أن تزول الشمس ولم تصلّ الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال: نعم(٢) .
ومقتضى الرواية الأخيرة وجوب القضاء بمجرّد كون الحيض بعد الزوال وان لم
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب ٤٨ من أبواب الحيض، ح ٤، ج ٢، ص ٥٩٧.
(٢) وسائل الشيعة: ب حكم قضاء الحائض، من أبواب الحيض، ح ٥، ج ٢، ص ٥٩٧.
يمض مقدار ركعة فضلاً عن غيره. وإن أمكن دعوى انصرافها الى مضيّ المقدار المذكور.
وكيف كان فليس في الروايتين دلالة على عدم القضاء عند عدم مضيّ المقدار المذكور، إذ ليس فيهما ما يوجب قصر الحكم كما لا يخفى.
قولهقدسسره : « وإن كان قبل ذلك لم يجب ».
أقول: ظاهر العبارة كما عرفت سابقاً: أنّ القضاء انّما ينتفي وجوبها فيما إذا لم يكن الزمان وافياً بقضاء الطهارة مطلقاً، والصلاة خفيفاً، ولو اضطرارياً، وقد عرفت إمكان انصرافها إلى اعتبار الطهارة المائية، والصلاة الأختيارية، وعليه فهل يعتبر أيضاً كون الزمان وافياً بتحصيل ما ليس بحاصل، من مقدّمات المقدمات، كتحصيل الماء أو التراب للطهارة، واللباس للستر، وغير ذلك كما هو ظاهر جماعة(١) ممّن قارب عصرنا أو لا يعتبر ذلك كما هو ظاهر الذكرى(٢) ، بناءً على ظهور مضيّ مقدار سائر الشرائط لفاقدها في مضي مقدار أنفسها، بل يمكن دعوى عدم اعتبار مضيّ مقدار سائر الشرائط، يعني إذا كان الحيض قبل مضيّ مقدار الطهارة والصلاة لم يجب القضاء، ومقتضاه عدم الوجوب ولو مضى مقدار أكثر الصلاة.
والمحكيّ عن السيد في الجمل(٣) وأبي علي(٤) ، وجوب القضاء إذا مضى مقدار أكثر الصلاة، لخبر أبي الورد، سأل أبا جعفرعليهالسلام عن المرأة تكون في صلاة
____________________
(١) تعليقة أستدلالية على العروة « للفقيه المحقق » ضياء الدين العراقي، ص ٦١، مسألة ٣١.
(٢) ذكرى الشيعة: مبحث الأستحاضة وأحكام الحائض: ص ٣١، س ٧.
(٣) رسائل الشريف المرتضى: في احكام قضاء الصلاة، ج ٣، ص ٣٨، س ١٣.
(٤) مختلف الشيعة: في غسل الحائض ج ١، ص ٣٩، س ٣١، والقول منسوب لابن بابويه وليس لأبي علي.
الظهر و قد صلّت ركعتين ، ثمّ ترى الدم ، قال: تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين. قال: فإن رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها، فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب(١) .
والظاهر: أنّ مراد السيد من مضيّ مقدار الأكثر مضيّه مع مقدار الطهارة لمن فقدتها، إذ الرواية على تقدير دلالتها وصحّة التمسّك بها لا يفي بأزيد من ذلك.
وعن المقنع(٢) والفقيه(٣) الإفتاء بمضمون الرواية.
وعن العلاّمة في نهاية الأحكام(٤) إحتمال وجوب القضاء إذا مضى مقدار الصلاة خاصة، معلّلاً بإمكان حصول الطهارة بتقديمها على الوقت، قال: إلاّ إذا لم يجز تقديمها الطهارة كالمتيمّم والمستحاضة.
وعنه في التذكرة(٥) يعلّل اعتبار مضيّ مقدار الطهارة، زيادة على مقدار الصلاة، بأنّه لا صلاة إلاّ بطهور، ومقتضاه عدم اعتبار مضيّ سائر الشرائط الاخر، إذ الصلاة لا تنتفي بانتفائها، بل مقتضاه عدم اعتبار مضيّ مقدار الطهارة المائيّة، بل والأجزاء الاختيارية.
ويمكن أن يقال: انّ هذا ظاهر كثير من معتبري مضيّ مقدار الطهارة ساكتين عن غيرها، إلاّ أنّ المحكي عن الذكرى(٦) التصريح باعتبار مضيّ مقدار باقي الشرائط مع فقدها. و قد صرّح بذلك كثير ممن تأخّر عنه(٧) ، بل ظاهر كثير ممّن
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب حكم قضاء الحائض الصلاة التي تحيض في وقتها، من أبواب الحيض، ح ٣، ج ٢، ص ٥٩٧.
(٢) المقنع « من الجوامع الفقهية »، ب الحائض والأستحاضة، ص ٥، س ٢٧.
(٣) من لا يحضره الفقيه: ب غسل الحيض والنفاس، ج ١، ص ٩٣.
(٤) نهاية الاحكام: في الحيض: ج ١ ص ١٢٣.
(٥) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة، ج ١، ص ٢٨، ٣١.
(٦) ذكرى الشيعة: في الحيض، ص ٣٥، س ٥.
(٧) مسالك الأفهام: في الحيض، ج ١، ص ٩ س ٢٨.
قارب عصرنا(١) اشتراط مضيّ مقدار يصحّ معه التكليف بالصلاة، وهو يقتضي عدم القضاء لو لم يتمكّن من الصلاة بالطهارة المائية، لاحتياج تحصيله إلى مقدار زمان كثير يسع لأكثر من صلاة.
وما أبعد ما بين هذا، وما عن ظاهر من قبل المصنّف من اعتبار مضيّ مقدار الصلاة. بل وما عن ظاهر النهاية(٢) ، والوسيلة(٣) من إيجاب القضاء إذا كان الحيض بعد دخول الوقت.
فتلخّص أنّ مناط سقوط القضاء، يحتمل أن يكون حدوث الحيض قبل دخول وقت العبادة، كما عن ظاهر النهاية(٤) والوسيلة(٥) ، ويحتمل أن يكون حدوثه قبل مضيّ مقدار الصلاة خاصّة لمن لم يتمكّن من تحصيل الطهارة الواجبة في حقّه، مع قطع النظر عن الحيض قبل دخول الوقت، ومضيّ مقدارها والطهارة لمن لا يتمكّن من ذلك كما هو ظاهر المحكيّ عن نهاية العلاّمة(٦) .
ويحتمل أن يكون حدوثه قبل مضيّ مقدار الطهارة وأكثر الصلاة، وسائر الشرائط الاختيارية، كما هو ظاهر المحكيّ عن السيدقدسسره في الجمل(٧) ، لما عرفت من أنّ الرواية التي استدلّ بها لا تقتضي عدم اعتبار الشرائط في ثبوت القضاء.
ويحتمل أن يكون حدوثه قبل مضيّ مقدار الطهارة والصلاة وسائر الشرائط أنفسها، كما هو ظاهر المحكيّ عن الذكرى(٨) .
ويحتمل أن يكون حدوثه قبل مضيّ مقدار الصلاة وما يعتبر فيها اختياراً
____________________
(١) تعليقة أستدلالية على العروة « للمحقق ضياء الدين العراقي »، ص ٦١، مسألة ٣١.
(٢) و (٣) النهاية: باب حكم الحائض والمستحاضة والنفساء وغيرهن، ص ٢٧.
(٤) و (٥) الوسيلة : في بيان احكام الحيض، ص ٥٩.
(٦) نهاية الأحكام: في الحيض، ج ١، ص ١١٩.
(٧) الجمل والعقود « رسائل الشريف المرتضى ». المجموعة الثالثة، في أحكام قضاء الصلاة ، ص ٣٨.
(٨) ذكرى الشيعة: الاستحاضة وأحكام الحائض، ص ٣٥ ، س ٥.
واضطراراً، كما هو ظاهر التذكرة(١) ، نظراً إلى التعليل المحكي.
ويحتمل أن يكون حدوثه قبل مضيّ زمان يصحّ معه التكليف بالصلاة الجامعة للشرائط الواجبة بحسب حالها، مع قطع النظر عن مانعيّة الحيض. وقد عرفت الفرق بين هذا وما عن ظاهر المحكيّ عن الذكرى، فلا نطيل بالإعادة.
حجّة معتبري حصول جميع الشرائط بأجمعها في وجوب القضاء: اصالة البراءة بعد اختصاص أدلّة القضاء بالفوت المنفيّ صدقه هنا.
وفيه كما قيل: انّه يكفي في صدق الفوت مجرّد محبوبية الفعل لو قدر عليه، واتي به أو هي مع إمكان صدور الفعل منه في الجملة، بأن يكون قبل الوقت جامعاً للشرائط، وحينئذٍ يقوى احتمال نهاية الأحكام من كفاية مضيّ مقدار صلاة بأجزائها الاختيارية، ولو لم يحصل شيء من شروطها.
وردّ ذلك بعد تسليم صدق الفوت، أنّ أدلة رفع القضاء عن الحائض، يدلّ على أنّ كل صلاة فاتت وكان فوتها مستنداً الى الحيض لا يجب قضاؤها، ولا ريب أنّ فوت الصلاة هنا مستند إلى الحيض فلا يجب قضاؤها.
ويمكن المناقشة في ذلك: بأنّ استناد فوت الصلاة ما إذا أدركت من الوقت مقدار فعل الصلاة، إذا كانت جامعة للشرائط إلى الحيض، كإستناد الشيء إلى بعض أجزاء علله، فانّ ارتفاع التكليف بالصلاة في الفرض المذكور مختصّ بانتفاء الشرائط في أوّل الوقت، وحدوث الحيض بعد مضيّ المقدار المذكور، إذ لو فرض وجود الشرائط لكان التكليف متحقّقاً، ولم يكن فوت الصلاة لازماً ولو كان الحيض طارئاً بعده، ونحن لا نسلّم أنّ الفوت إذا استند إلى الحيض بأيّ نحو من الاستناد كان كافياً في سقوط القضاء، إذ غاية ما يدلّ عليه أدلّة عدم لزوم القضاء على الحائض هو أنّ كلّ ما ترك في زمان الحيض - وكان استناد فوته إليه، لتوقّفه على عدمه - لا يجب قضاؤه، وأمّا مجرّد استناد فوت الشيء إلى الحيض، فلا يدلّ على
____________________
(١) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة، ج ١ ، ص ٢٨، س ٣١.
أنّه لا يوجب القضاء.
والحاصل: أنّ محبوبية الفعل مع إمكان صدور الفعل في الجملة إذا كانت كافية في صدق الفوت، صحّ حينئذٍ أن يقال: فوّت الصلاة على الظاهر إذا مضى من الوقت مقدار نفس الصلاة، وغاية ما يستفاد من أدلّة عدم وجوب القضاء: هو أنّ ما فات على الحائض لا يجب قضاؤه.
وبعبارة اخرى: لا إشكال في أنّ فوت الصلاة في ما عدا مقدار الصلاة في أوّل الوقت مستند بالحيض، وتركه في ذلك الوقت مستند بترك المقدّمات قبل الوقت، وفوت الطبيعة في مجموع الوقت يتحقّق بفوتها، وكما يصدق أنّه فات على الحائض بملاحظة الحيض اللاحق، كذلك يصدق أنّه فات على الطاهر بملاحظة السابق، والدليل يرفع قضاء فوات الحائض خاصّة.
ثمّ إنّ هنا إشكالاً آخر على تقدير تسليم عدم صدق الفوت، أو صدقه، والحكم بأن الفوت المستند الى الحيض بأيّ نحو من الإستناد كافٍ في عدم وجوب القضاء معه ذلك الاستناد مطلقاً، وهو أنّ مقتضى عمومات الأمر بالصلاة مع اختصاص أدلّة بعض الأجزاء والشرائط بصورة التمكّن أنّه لو علمت المرأة أنّها تحيض قبل زمان يسع لإدراك الصلاة بشرائطها وأجزائها الاختيارية، مع كون الزمان الذي تدركه ممّا يسع لفعل الصلاة الاضطرارية، وجوب ذلك الفعل الاضطراري، ومقتضى ذلك: وجوب القضاء إن تركت الاضطرارية لمانع آخر أو عصياناً، وحينئذٍ فأيّ فرق بين ما لو علمت بأنّ الأمر كذلك أو فاجأها فانّ وجوب الاضطراري واقعاً عند الإضطرار لا يشترط فيه العلم بالاضطرار.
ودعوى أنّه فرق بين الضيق الذاتي كما إذا لم يتّسع زمان الكسوف مثلاً لأداء صلاته مع الطهارة المائيّة، وبين العرضي الحاصل بحدوث المانع عن بقاء التكليف كما في ما نحن فيه بإلتزام وجوب الإضطراري في الأوّل دون الثاني.
دعوى بلا بيّنة، إذ قد عرفت أنّ مقتضى اختصاص أدلّة الشرائط والأجزاء الاختيارية ثبوت الإضطراري بمجرد المانع.
وقد اجيب عن ذلك بوجهين:
أحدهما: أنّا لا نسلّم وجوب الإنتقال إلى الإضطراري لأيّ مانع كان، بل المسلّم هو ما إذا كان التكليف بالإختياري ثابتاً ثمّ عرض الإضطرار، وأمّا مع عدم سعة الزمان بواسطة طروّ المانع لفعل الإختياري فلا نسلّم وجوب الإنتقال إلى الإضطراري.
وثانيهما: أنّ وجوب الإضطراري لا يلازم ثبوت القضاء، وذلك بأنّ القضاء تدارك للإختياري الذي أستند فوته إلى الحيض، وليس تداركاً للإضطراري الواجب بسبب الإضطرار، ولذا لا يجب مطابقته للإضطراري في الأجزاء والشرائط، بل لا يجوز الإتيان به مطابقاً للإضطراري، ولو كان تداركاً له لوجب مطابقته له، ولذا يجب قضاء الفائت في السفر قصراً، وإن كان القاضي حاضراً. ومقتضى إطلاق أدلّة سقوط القضاء عن الحائض سقوطه إذا كان فوت ما يقضي - لولا السقوط - مستنداً إلى الحيض وجب تداركه في الوقت واقعاً ببدله الإضطراري أم لم يجب واختصاصه بالثاني في محلّ المنع.
وفي كلا الوجهين نظر.
أمّا في الأوّل فيظهر وجهه من التأمّل في أصل الإشكال، وتوضيحه: أنّ إطلاق الأمر بالصلاة الجامع بين الإضطراري والإختياري، بعد سلامته عن التقييد بالجامع للشرائط والأجزاء الإختيارية لاختصاصها بالتمكّن، موجب لفعل الإضطراري في حال عدم التمكّن من الإختياري.
بقي الكلام في وجوب الصلاة مع الطهارة الترابية عند عدم التمكّن من استعمال الماء لضيق الوقت، ويمكن أن يقال هنا أيضاً: إنّ المعلوم من تتّبع الموارد - بعد ثبوت عدم اختصاص وجوب التيمّم بصورة فقدان الماء في الجملة - أنّ كل عذر ومانع عن استعمال الماء مسوّغ للتيمّم من غير فرق بين أقسام العذر.
وأمّا في الثاني فلأنّا لا نسلّم أن القضاء تدارك للصلاة الأختيارية، بل هو تدارك لما وجب على المكلّف وفات عنه، وهو الجامع بين الإختياري
والإضطراري، غاية الأمر أنّ الواجب عليه باختلاف حالاته، هو فرد خاص من أفراده، ولذا يجب على المصلّي قضاءً، إذ ظن الموت، أن يقضي الصلاة مع التيمّم إذا لم يجد الماء للوضوء.
والحاصل: أنّ الواجب الأصلي الذي يجب تداركه ولا يسقط بحال، أداءً وقضاءً، هو الجامع بين كلّ واحد من أصناف الصلاة، والواجب عليه في كلّ حال ما يناسب ذلك الحال، فإذا وجب ذلك في ضمن فرد منه على المكلّف ولم يسقط بعروض الحيض وجب قضاؤه، لأنّ ما فات على الظاهر يجب قضاؤه فظهرأنّه يجب على من يسلّم صدق الوقت مع إدراك الوقت بمقدار فعل الصلاة إذا كانت جامعة للشرائط، أن يحكم بأنّه مع التمكّن من الصلاة الإضطرارية في الوقت يجب القضاء، وكذا مع عدم التمكّن منها إذا كان منشأ عدم التمكّن عدم تحصيل الشرط قبل الوقت، كما إذا كان قبل الوقت واجدة للماء فلم تتوضأ، وفقدته في الوقت مع عدم التمكّن من الطهارة الترابية، وقد أدركت من الوقت مقداراً يفي بأداء الصلاة إذا كانت واجدة للشرط، وهذا ينافي ظاهر الأكثر، فأنّ الظاهر اعتبارهم لسعة الوقت لفعل الصلاة مع الطهارة في الجملة لو كانت فاقدة لها، هذا.
ويمكن دفع الإشكال، أعني وجوب الانتقال إلى الإضطراري، بأنّ الامور الطارئة على المكلّف الموجبة لإرتفاع التكليف ثلاثة أقسام:
منها: ما يكون رفعها للتكليف لمجرد معذورية المكلّف كالأعذار العقليّة، كالنوم والنسيان، والشرعيّة كالمرض والضرر.
ومنها: ما يكون مع ذلك مخرجة للمكلّف عن قابلية التكليف، مع قطع النظر عن المعذورية العقلية، كالجنون والإغماء، فانّهما بمنزلة الصغر في إخراج المكلّف عن قابلية التكليف، ولو فرض محالاً انتفاء العذر العقلي.
ومنها: ما يكون وسطاً بين الأمرين في كون المكلّف معه قابلاً للخطاب والتكليف عقلاً، ولكنّه مخرج له عن قابلية التكليف شرعاً كالحيض، فإذا كان العذر الموجب طريانه لضيق الوقت عن أداء الإختياري من القسم الأوّل لم يوجب
رفع التكليف رأساً، بل هو رافع له بمقدار ما يقتضي العقل رفعه، فيبقي معه التكليف بالإضطراري. وإذا كان الأمر الطارئ من الأخيرين فلا يوجب ذلك الإنتقال الى الإضطراري، فأنّ القدر المسلّم الذي يستفاد من مجموع الأدلّة هو أنّه إذا كان المكلّف معذوراً من أداء الأختياري وكان له مع العذر قابليّة التكليف شرعاً وجب عليه الإضطراري، وأمّا بدونه فلا دليل على قيام الإضطراري مقام الإختياري، ولذا نقول: بأن من علم من حاله عروض الجنون في الوقت قبل زمان يسع لأداء الاختياري أنّه لا يجب فعل الإضطراري، وكذلك من اعتاد الإغماء.
فإن قلت: خروج المكلّف عن قابليّة التكليف بالإضطراري لأجل تدارك ما يفوت بالعذر المخرج عن قابلية التكليف، وأمّا مع كون الزمان قابلاً في نفسه لأداء المكلّف به ولو منع العذر عن الاتيان بالفعل عند طروّ العذر، وكان المانع عن الفعل في الزمان الخالي عن العذر عدم تحصيل المكلّف للشرائط المقدورة له قبل حلول وقت الواجب، فقابلية ذلك للتكليف يوجب الإنتقال إلى الإضطراري.
والحاصل: أنّ التي أدركت من الوقت مقداراً يسع للصلاة، أنّما نقول بوجوب الصلاة عليها مع الشرائط الإضطرارية بملاحظة قابلية ذلك الزمان للتكليف، لا بملاحظة ما يخرج فيه عن قابلية التكليف بواسطة طروّ العذر.
وبعبارة اخرى: إذا كان جهة إرتفاع الإختياري خروج المكلّف قبل زمان يسع له عن قابلية التكليف كان الوجه عدم الإنتقال كما ذكرت، وأمّا إذا كان سوء اختياره لترك المقدّمة قبل حلول الوقت فلا مانع من وجوب الإضطراري عليه.
وبعبارة ثالثة: عدم الدليل على الإنتقال من الإختياري الى الإضطراري، إذا كان المانع عنه طروّ العذر المخرج للمكلّف عن قابلية التكليف أو وجود الدليل على عدمه لا ينافي وجوب الإنتقال لأجل منع المكلّف لنفسه عن الأداء، لتركه تحصيل الشرط عند القدرة عليه، فمن أدركت من الوقت ما يسع للصلاة، وقد فقدت بعض الشرائط لسوء إختيارها وعدم تحصيلها له عند القدرة، يجب عليها الإضطراري
لذلك، لا لأجل الضيق العارض بسبب طروّ العذر.
قلت: هذا بالنسبة إلى ما يجب تحصيله من المقدّمات قبل حلول وقت الواجب صحيح، وأمّا بالنسبة إلى ما لا يجب تحصيله كالطهارة فممنوع، فانّ الواجب على المكلّف حقيقةً عند حلول الوقت هو الصلاة والطهارة، والزمان اذا لم يسع لهما بالعرض، كان هذا الضيق بمنزلة الضيق الذاتي عن أداء الفعل، فكما أنّه لا يوجب الإنتقال إلى الإضطراري كذلك الضيق العرضي.
وبالجملة الزمان إذا لم يسع بنفسه لأداء الواجب لم يوجب ذلك الإنتقال إلى الإضطراري، والقطعة الخالية من الطارئ لعدم سعته في نفسه لأداء الواجب لا يوجب الإنتقال الى الإضطراري، وزمان العذر أيضاً لعدم بقاء التكليف فيه على القابلية لا يوجب الإنتقال، فلا موجب في مثل هذا الفرض للإنتقال إلى الإضطراري، ليكون موجباً للتكليف بالقضاء على تقدير فوته.
ثم إنّك قد عرفت: أنّ غاية ما يفي به أدلّة سقوط القضاء عن الحائض، هو أنّ ما فات في زمان الحيض به إذا كان له قضاء، مع قطع النظر عن الحيض لو فات، لا يوجب فوته بالحيض القضاء، فالزمان الخالي عن الحيض لا يوجب طروّ الحيض ولحوقه به رفع القضاء الثابت لأجل ذلك الزمان، ومقتضى ذلك أنّ من أدركت من الوقت بمقدار أداء الصلاة لو كانت مع الطهارة يجب عليها القضاء، وإن لم توجب عليها حينئذٍ الإنتقال إلى الإضطراري إذا علمت بحالها، بناءً على ما مرّ من صدق الفوت على الظاهر الموجب للأمر بالقضاء، أو على أنّ مناط القضاء ليس هو الفوت، بل الترك وإن لم يصدق عليه الفوت.
ويمكن أن يقال: أوّلاً: أنّا نمنع صدق الفوت في مثل الفرض المذكور، لأنّ الفوت هو ترك ما يلزم فعله في حدّ نفسه، وذلك أنّما يصدق إذا كان التكليف بسبب حصول جميع شرائطه التي اعتبر في حصوله شرعاً مع قطع النظر عن الأعذار العقلية مقتضياً للفعل، وكان الترك مستنداً إمّا إلى عذر عقلي لم يؤخذ عدمه في دليل ثبوت التكليف، وكان ارتفاع التكليف معه بحكم العقل، لا بالنظر إلى إنتفاء
شرط التكليف المأخوذ في ظاهر الدليل، أو أمر آخر كسوء اختيار المكلف مثلاً ونحن نمنع أنّ التكليف هنا مقتضى بهذا المعنى، لأنّ حصول الطهارة اعتبر في حصول هذا التكليف شرعاً، فاقتضاء التكليف مقيّد بذلك، ومع عدمه لا إقتضاء له.
بيان ذلكك أنّه لا إشكال في أنّ الطهارة انّما تجب بدخول الوقت، نظراً إلى قولهعليهالسلام : إذ دخل الوقت وجب الطهور والصلاة(١) . ومقتضى ذلك: تقييد وجوب الصلاة في أوّل الوقت بحصول الطهارة، إذ لا يعقل الجمع بين إطلاق الأمر بالصلاة في أوّل الوقت، والترخيص في ترك ما يتوقّف عليه، فيكون مورد التكليف بالصلاة في أوّل الوقت المتطهّر عند ذلك، فإذا كان المكلّف فاقداً للطهارة لم يقتضي ذلك في حقّه فعل الصلاة، فلا يكون تركه لها فوتاً. وهذا الكلام جار بالنسبة إلى كلّ شرط غير حاصل يوجب عدمه ترك الصلاة، إذا ثبت كون الإذن في تركه حاصلاً قبل الوقت، فالفرق بين الشرائط في صدق الفوت على الترك المستند إليه وعدمه بالنظر إلى هذا الإعتبار، فما كان الواجب بالنسبة إلى حصوله في أوّل الوقت مطلقاً صحّ أن يقال فيما يترك به أنّه فات ذلك، وما كان مقيّداً بحصوله لم يصحّ ذلك، ولأجل هذا نفرّق بين مقدّمات الفعل ومقدّمات مقدّماته، وبين المقدّمات أيضاً بالنسبة إلى الطهارة وغيرها.
ويمكن أن يقال أيضاً: إنّ الفوت هو ترك ماله قوة قريبة للحصول، فإذا كان الزمان غير وافٍ لنفس الفعل، أو لما يكون شرطاً فيه شرعاً مع الترخيص في ترك ذلك الشرط قبل الوقت، لا يصحّ أن يقال: انّه فات في ذلك الوقت، لأنّ نسبة الفوت إلى الزمان تابع لقابليته لوقوع الفعل فيه.
ويمكن أن يقال ايضاً: انّ كل مقدّمة كان حصوله في أوّل الوقت غالباً فاتّفق فوته، كان الترك المستند إليه فوتاً، وما لم يكن كذلك لم يصدق عليه ذلك، لأنّ
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب في أن غسل الجنابة يجب للصلاة، من أبواب الجنابة، ح ٢، ج ١، ص ٤٨٣.
الفعل مع هذا الحال ليس له قوة قريبة يوجب حصوله، ومناط صدق الفوت هو ذلك، فتأمّل.
هذا كلّه على تقدير كون مناط القضاء الفوت، ولو كان مناطه الترك أيضاً نقول: ليس كلّ ترك موجباً للقضاء، وإلاّ لوجب على الصغير والمجنون قضاء ما فات منهما في حال الصغر والجنون، وتسليم العموم، ودعوى خروج ما خرج، أقبح شيء يلتزم في المقام، بل الترك الموجب للقضاء هو الترك على وجه كان اقتضاء التكليف من حيث شرائطه المأخوذة تامة بحيث كان للفعل بصفة الوجوب قوّة قريبة يصحّ معه أن يقال عرفاً ترك الواجب، وإن لم يكن في الواقع حال الترك واجباً، بواسطة حصول أحد الأعذار العقلية، كالنوم والنسيان مثلاً، فإذا فرض أنّ وجوب الواجب مقيّد شرعاً بحصول بعض مقدّماته لم يصحّ أن يقال: انّ تركه المسبّب عن إنتفاء تلك المقدّمة موجب للقضاء، لأنّ الواجب لم يترك بصفة الوجوب عرفاً، فكلّ مقدّمة كانت قيداً للتكليف اعتبر حصوله في وجوب القضاء، وما لم يكن كذلك بل كان الوجوب بالنسبة إليه مطلقاً، كان فوت الواجب المستند إليه موجباً للقضاء، لصحّة أن يقال: ترك الواجب.
ومن هنا يتأتّى الفرق بين صلاة الحائض بين المقدّمات، وبين مقدّمات المقدّمات.
فتلخّص من جميع ما ذكرنا: أنّ التكليف بالصلاة الإختيارية في أوّل الوقت، مع قطع النظر عن أدلّة البدلية، إن لم يكن مشروطاً بشيء من المقدّمات وحصولها في الوقت، وكان الوقت أيضاً قيداً للمكلّف به، لا للتكليف وشرطاً فيه، كان مقتضى القاعدة إيجاب القضاء على من أدركت من الوقت مقداراً يفي بأجزاء الصلاة، لأنّه مكلّف حينئذٍ بذلك، غاية الأمر أنّ الجهل بطروّ العذر صيّر المكلّف معذوراً في الترك. وإن قلنا أنّه مشروط. بحصول جميع المقدّمات، أوقلنا بأنّ الوقت شرط التكليف ولا يجب تحصيل مقدّمات العبادة قبل حلول الوقت، لم يجب القضاء من جهة فوت الاختياري بشيء من الشرائط، ولزم اختيار ما حكيناه عن ظاهر
كثير من المتأخّرين، من اعتبارهم في وجوب القضاء مضيّ زمان يصحّ معه التكليف بالفعل. وإن قلنا: إنّ التكليف غير مقيّد بالنسبة إلى بعض المقدّمات كوجود الماء وتحصيله، ومقيّد بالنسبة الى بعض كوجود الطهارة من الحدث، وقلنا: إنّ الواجب معلّق على الوقت، وجب اختيار ما ذكرناه من وجوب القضاء إذا استند الترك إلى فوت مقدّمات المقدّمات وعدمه، أو استند إلى نفس المقدّمات كالستر والطهارة مثلاً، وذلك بالنسبة إلى الطهارة غير بعيد، بل هو الأقوى، وبالنسبة الى غيره فغير بعيد أيضاً.
وأمّا بملاحظة أدلّة البدليّة فنقول: أدلّة البدلية غير صالحة لإثبات البدل من جهة الضيق الحاصل بالحيض، ولإثبات البدل من جهة نفس الزمان الذي يصلح لأداء الفعل في نفسه لو اجتمع الشرائط، لما عرفت أنّها لا تفيء بإثبات البدل من جهة الضيق الحاصل بطروّ الأعذار المخرجة للمكلّف عن قابلية التكليف شرعاً، ولإثبات البدل في الضيق الذاتي وما في حكمه. فلو أدركت من الوقت مقداراً لا يفي إلاّ بالصلاة لم يكن الإضطراري واجباً، ولو أدركت قدر الصلاة ومقدّماتها الأوّلية كان الإنتقال إلى البدل واجباً، لا لأجل الضيق الحاصل بالحيض، بل لأنّ وفاء الوقت بالمقدّمات الشرعية يخرج ذلك الوقت عن عنوان الضيق الذاتي، لأنّ ما يراد إثباته في الوقت لا يكون زائداً على الوقت وهو وافٍ به، فانتفاء الإختياري لأجل العذر المصحّح للانتقال إلى الاضطراري، فالأقوى وجوب القضاء إذا أدركت من الوقت مقدار الصلاة ومقدّماتها الإبتدائية، ووجوب الإضطراري في ذلك الوقت إذا علمت بالحال، وعدم وجوب القضاء والأداء في غير هذه الصورة، إلاّ أنّ ظاهر بعض الأخبار وجوب القضاء اذا كان حدوث الحيض بعد زوال الشمس، كظاهر رواية ابن الحجاج(١) المتقدّمة، وإن لم يبعد دعوى انصرافها إلى مضيّ مقدار الصلاة.
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب حكم قضاء الحائض الصلاة، ح ٥ ، ج ٢، ص ٥٩٧.
وكيف كان فالظاهر أنّه لا خلاف في عدم وجوب القضاء في هذه الصورة، وظاهر بعض آخر والمحكيّ عن السيد في الجمل(١) والأسكافي(٢) وجوب القضاء إذا أدركت مقدار أكثر الصلاة.
وربّما يحتجّ لهم برواية ابن الحجاج بعد منع انصرافها الى مضيّ مقدار الصلاة، بتقريب أنّ مقتضى عمومها وجوب القضاء، إذا كان الحيض بعد الزوال، أدركت مقدار أكثر الصلاة أو لم تدرك، خرج الصورة الأخيرة بالإجماع.
وبرواية أبي الورد: عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر، وقد صلّت ركعتين، ثمّ ترى الدم، قالعليهالسلام : تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين، قال: فإن رأت الدم وهي في صلاة المغرب، وقد صلّت ركعتين، فلتقم من مسجدها، فإذا تطهّرت فلتقضي الركعة التي فاتتها من المغرب(٣) . وهي مع شذوذها، ومخالفتها للإجماع المحكي عن الخلاف(٤) على خلافها، ضعيفة سنداً ودلالة، فأنّ دلالتها على وجوب قضاء تمام الصلاة في فرض المغرب الذي أدركت من الوقت بمقدار أكثره، أنّما هو بعد حمل قضاء الركعة على تمام الصلاة، بضميمة الإجماع على أن الركعة المنفردة لا تقضى.
ومن هنا ظهر وجه ضعف آخر للرواية، حيث إنّ ظاهرها ممّا لا يقول به أحد، ولذا حمل في المختلف(٥) الرواية على التقصير في المغرب دون الظهر.
وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في ضعف القول المذكور.
ثمّ إنّك عرفت أنّ المناط في وجوب القضاء إدراك الصلاة وما يعتبر فيها من الشرائط بحسب حال المكلّف في زمان طروّ الحيض، فلو كان وظيفة الحائض
____________________
(١) رسائل الشريف المرتضى « المجموعة الثالثة »، فصل أحكام قضاء الصلاة، ص ٣٨ ، س ١٣.
(٢) لم نعثر عليه.
(٣) وسائل الشيعة: ب ٤٨ من أبواب الحيض، ح ٣، ج ٢، ص ٥٩٧.
(٤) الخلاف: كتاب الحيض والاستحاضة، ج ١، مسألة ١٨، ص ٧٠.
(٥) مختلف الشيعة: فصل غسل الحائض وأحكامه، ج ١، ص ٣٩، س ٣٧.
التيمّم لو لم تكن حائضاً لأجل فقدان الماء مثلاً وجب عليها الصلاة مع التيمّم لو أدركت من الوقت مقدار كذا، ومع الترك جهلاً بالحال، أو عمداً يجب القضاء، ووجوب التأخير عليها إلى آخر الوقت لا يمنع ممّا ذكرنا، لأنّ المراد أخّر ما يمكن وقوع الفعل فيه، فالحيض، مضيّق للزمان، لأنّه يخرج الزمان عن الإمكان، لا أنّه رافع للتكليف محضاً.
هذا كلّه حال من أدركت الطهر في أوّل الوقت، وأمّا من أدركته في آخر الوقت فلا يخلو إمّا أن يكون الزمان وافياً لتحصيل الشرائط الغير الحاصلة، أم لا. أمّا على الأوّل، فلا تأمّل ولا إشكال في وجوب القضاء، وكذا الأداء، وإن لم يسع الزمان لإدراك الصلاة فإن كان يسع لإدراك ركعة وجب القضاء لقولهعليهالسلام : من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك [ الوقت ](١) كلّه، وقولهعليهالسلام في مصحّحة عبيد بن زرارة: أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة معيّنة، ففرّطت فيها حتى يدخل وقت صلاة اخرى، كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها، وإن رأت الطهر في وقت صلاة، فقامت في تهيئة ذلك، فجاز وقت الصلاة ودخل وقت صلاة اخرى، فليس عليها قضاء(٢) ، وصحيحة الحلبي: في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي الظهر حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت، أتقضي الصلاة التي فاتتها؟ فقال: إن كانت توانت قضتها، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي(٣) .
دلّ الروايتان الأخيرتان على وجوب القضاء على من أدركت من الوقت مقدار الطهارة والصلاة بل وسائر الشرائط، والرواية الاولى دلّت على أنّ من أدركت ركعة من الوقت جامعة للشرائط، وجب عليها الصلاة، وهي بحكم مدرك الوقت، وإن لم
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب أنّ من صلّى ركعة ثم خرج الوقت، من أبواب الصلاة، ح ٤، ج ٣، ص ١٥٨.
(٢) وسائل الشيعة: ب وجوب قضاء الحائض الصلاة، ح ١، ج ٢، ص ٥٩٨.
(٣) وسائل الشيعة : ب وجوب قضاء الحائض الصلاة، ح ٨ ، ج ٢ ، ص ٥٩٩ و ٦٠٠. الاّ انّ بدل الظهر « ظهرها ».
يسع الزمان لإدراك التمام، ولا الركعة من الصلاة جامعة للشرائط، فقد يكون ذلك لأجل ضيق نفس الزمان عن الإتيان بمقدّمات الصلاة الشرعية، كالوضوء والستر مثلاً، وقد يكون لأجل ضيق الزمان عن تحصيل ما ليس بحاصل من المقدّمات العقليّة، كوجود الماء، فإن كان من قبيل الأوّل، فالظاهر أيضاً عدم وجوب القضاء والأداء، أمّا الأداء فلأنّ الإختياري، مفروض التعذّر، والإضطراري لا دليل على كونه بدلاً، وأمّا القضاء فلأنّه تابع للفوت أو صدق ترك الواجب عرفاً، والكلّ منتفٍ ، وإن كان من الثاني أيضاً، أمكن أن يقال بسقوط القضاء، نظراً إلى اشتراط التكليف بامور يضيق الزمان عن الإتيان بها، فهو غير حاصل، فلا يصدق على الترك أنّه فوّت أو ترك للواجب، فلا يجب القضاء.
ويمكن أن يقال بثبوت القضاء والإنتقال إلى الإضطراري، أمّا الإنتقال فلعموم أدلّة البدلية، وعدم المانع.
ودعوى: أنّ الزمان لا يفي بالواجب، وقد ثبت على أنّ الإنتقال إلى الإضطراري انمّا هو في غير الضيق الذاتي.
مدفوعة: بأنّ الواجب الشرعي يسع له الزمان، وانّما منع عن التكليف، العذر العقلي، وأمّا القضاء فلصدق الفوت، وترك الواجب.
ثمّ إنّ من اعتبر في وجوب القضاء في أوّل الوقت مضي زمان يصحّ معه التكليف، ظاهره اعتبار ذلك هنا أيضاً، وأنّه لا يجب الإنتقال إلى الإضطراري أيضاً، فمن أدركت من الوقت مقداراً يفي بالغسل والصلاة، ولكن تحصيل الماء يحتاج إلى زمان كثير، ولأجل ذلك لا تقدر على الصلاة مع الطهارة، لا يجب عليها الأداء والقضاء، بناءً على ذلك.
إلاّ أن يقال: انّه فرق بين ما نحن فيه وما سبق، بأن يقال: انّ ترك الصلاة في هذا الفرض مستند عرفاً إلى غير الحيض، لأنّ الجزء الأخير غيره، وقد فرض أنّ الفائت بالحيض أعني المستند اليه لا يجب قضاؤه.
ولكن الإنصاف: أنّ الفرق مشكل أو ضعيف.
ثمّ إنّك بعد التأمّل في ما ذكرنا تعرف أنّ الواجب بالنسبة إلى مقدّماته مطلق، ومشروط، ومعلّق، وهذه المسألة وإن كانت اصولية، إلاّ أنّ التعرّض لها في هذا المقام ممّا لا بأس به، لارتباط له بالمقصود تعرف وجهه إن شاء اللّه تعالى.
فنقول: لا إشكال ولا ريب في أنّ وجوب المقدّمة معلول وجوب ذي المقدّمة، بمعنى أنّه متى تحقّق وجوب ذي المقدمة، وجب(١) المقدّمة بنحو من الوجوب الثابت لذي المقدمة، مطلقاً كان أو مشروطاً، وتنجّز وجوب المقدّمة تابع لتنجّز وجوب ذي المقدّمة، بمعنى أنّه يكون تنجّز طلب ذي المقدمة سابقاً في الرتبة على تنجّز طلب المقدّمة، فلا يعقل تحقّق الوجوب الغيري المتعلّق بالمقدّمة وتنجّزه، قبل تحقّق طلب ذي المقدّمة وتنجّزه، ولا يكفي في صحّة تنجّز طلب المقدمة سبق الإنشاء للطلب المشروط المتعلّق بذي المقدمة، إذ قد عرفت أنّ كل مرتبة من مراتب طلب المقدّمة تابع لنظيره من تلك المرتبة لطلب ذي المقدّمة.
ومن هنا أشكل الأمر على جماعة من العلماء في مثل صوم شهر رمضان بالنسبة إلى وجوب الغسل في الليل، فانّ وجوب الصوم لا إشكال في أنّه مشروط بدخول الوقت، والغسل لا يكون إلاّ مقدّمة للصوم، فكيف يجب متنجّزاً قبل تنجّز وجوب الصوم؟ وله نظائر كثيرة في الفقه يقف عليها المتتبع.
وقد اجيب عن هذا الإشكال بوجوه، منها: ما ذكره صاحب الفصول(٢) وحاصله: أنّ الوقت هنا قيد للواجب لا الوجوب، فالواجب بالنسبة إلى الوقت مطلق، كإطلاقه بالنسبة إلى سائر مقدّماته، ولازم ذلك تحقّق الوجوب قبل دخول الوقت، ويلزمه تحقّق معلولاته عن الوجوبات الاخر المتعلّقة بالمقدّمات، وليس مرادنا من الإطلاق: أنّه لا يكون للواجب من هذه الجهة قيد أصلاً، بل المراد: أنّ نفس دخول الوقت ليس شرطاً لتحقّق الوجوب حتى يلزمه تأخّر الوجوب عن دخول
____________________
(١) كذا، والصحيح: وجبت.
(٢) الفصول الغروية: ص ٩٠ - ٩١.
الوقت، بل الشرط هو الأمر المنتزع من دخول الوقت، وهو كون المكلّف بحيث يكون داخلاً في الوقت، وهذا الشرط حاصل قبل وجود المكلّف بألف عام، فضلاً عن ليلة الصيام، فلا يكون وجوب المقدّمة أبداً في مثل هذا الفرض إلاّ متأخّراً عن وجوب ذي المقدّمة، وليس تنجّز وجوبها أيضاً إلاّ متأخّراً عن تنجّز وجوب ذي المقدّمة، هذا مضافاً إلى النقض.
قوله(١) قدسسره : « و أمّا ما يتعلّق بها فأشياء، الأوّل : يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة كالصلاة ».
أقول: لا إشكال في أنّه يحرم على الحائض الصلاة بعنوان المشروعية، لأنّه تشريع محرّم بالأدلّة الأربعة، وإنما الإشكال في حرمتها ذاتاً، والظاهر أنّ موضع احتمال الحرمة الذاتيّة ليس هو ذات المركب الجعلي بما هي مع قطع النظر عن قصد التقرّب أو عنوان آخر، إذ الظاهر عدم التزام أحد بأنّ الصلاة بقصد التعليم محرّمة على الحائض، ولا الصلاة بقصد التقرّب جزماً أو احتمالاً، إذ لا يعقل النهي عنهما مع إمكانهما، لأنّ الإطاعة الجزميّة والاحتياط الراجع إلى الإطاعة الاحتمالية حسنهما ذاتي لا يعقل النهي أيضاً لأنّه كالأمر لا يتعلّق بغير المقدور، فمورده إمّا الصلاة تشريعاً، فيكون التشريع الخاصّ محرّماً من حيث كونه تشريعاً، ومن حيث كونه تشريعاً خاصّاً، وهذا أيضاً مشكل، نظراً إلى أنّ النواهي المتعلّقة بصلاة الحائض إن أمكن أن يقال: انّ ظاهر النهي عن الشيء أنّه بنفسه مورداً للحكم، لا باعتبار كونه مصداقاً لعنوان كلّي منطبق عليه، وإلاّ أنّ هذا لا يبلغ حدّ الاعتماد، مع أنّ الثمرة التي رتّبوها على القولين وهي
____________________
(١) من هنا موجود في نسخة طهران فقط الى ص ٣٣٧.
عدم حسن الاحتياط عند الشكّ في ثبوت الحيض لا يترتب على القول بالحرمة الذاتيّة بناءً على هذا الوجه، ضرورة مباينة الإحتياط من التشريع.
ويمكن أن يقال: انّ مورد النزاع هو فعل المركّب المجعول شرعاً بعنوان التخضّع والتذلّل وإظهار العبودية، فإنّ حقيقة الصلاة ليست هي نفس الفعل المحبوبي المركّبة من هيئات خاصّة عارضية على جسد المصلّي، من الإستقامة والإنحناء واللصوص(١) بالأرض من ألفاظ الخاصّة(٢) ، بل هو فعل مركّب من أفعال خاصّة مع اقتران كلّ واحد منها بقصد التخضّع والتذلّل، بل الظاهر أنّ ما يختصّ بها من الأسماء لا يصدق في بعضها عليه بدون هذا القصد كالسجود والركوع، فإنّ الظاهر أنّ قصد ذلك المفهوم مأخوذ فيهما، والظاهر أنّ فعل الصلاة بهذا العنوان كافٍ في سقوط الأمر، بل في إستحقاق الثواب، وليس المناط في ترتّب الثواب قصد الأمر، ولذا قيل: إنّ إتيان الفعل لتحصيل غرض الموالي أو لجهة الأمر كافٍ في حصول لثواب وسقوط الأمر التعبدي، بل الظاهر أنّه لا إشكال في أنّ السجود للّه تعالى إذا لم يلتفت الساجد إلى الأمر به وقد فعله تذلّلاً وخضوعاً يترتّب عليه أعلى مراتب الثواب المترتب على السجود، وأيضاً شاع وذاع وامتلأ(٣) كتب الأخبار حتى بلغ الأسماع أنّ البكاء خوفاً من العذاب يترتّب عليه ثواب كثير وأجر جزيل.
والحاصل: أنّ مناط ترتّب الثواب ليس قصد الأمر، والصلاة من هذا القبيل، ونظائرها كثيرة، وبهذا الوجه أيضاً يندفع إشكال اعتبار قصد التعبّد في الأوامر، فانّا نقول: إنّ القدر المعلوم اعتباره في العبادة هو هذا الخضوع الذي لا يتوقّف قصده إلاّ على العلم بكونه أدباً يليق الخضوع به، وقد كشف الشارع بالأمر عن ذلك، نعم
____________________
(١) اللص فعل الشيء في ستر. ج لصوص والصاص وهي لصّة وأرض ملصة كثير نعم واللصص تقارب المنكبين وتقارب الأضراس راجع القاموس المحيط: ج ٢ ص ٣١٧.
(٢) كذا والصحيح: خاصّة.
(٣) كذا والصحيح: وامتلأت.
يعتبر فيه أن لا يكون الغرض من هذا الخضوع إراءة الناس وإسماعهم أنّه داخل في سلك الخاضعين وفي زي العابدين، ليتناول من حطام الدنيا وأرجاسها، ويملك قلوب العباد وأموالها، ويدخل في دماء الناس وأعراضهم، عصمنا اللّه وجميع المؤمنين من مكائد الشيطان.
فإن قلت: إذا كان الصلاح هذا الذي ذكرت، وكان أدباً وحسناً ذاتياً كشف الشارع عنه، فكيف يصحّ النهي عنه في حال دون [ حال ] ؟ وهل هذا إلاّ كنهي عن الإطاعة ؟
قلت: إذا كان المكلّف لما به من الأرجاس في حال لا يليق بإظهار العبودية والدخول في معراج المؤمنين، كان فعل العبادة منه قبيحاً، وصحّ النهي عنه.
فإن قلت: إنا لا نعقل من الصلاة إلاّ ذوات أفعال مخصوصة بقصد التقرّب، وليس هذا المعنى داخلا في حقيقة الصلاة المكلّف بها الأحرار والعبيد، والوضيع والشريف، وضعفاء العقول من الناس، وأنّى لهم بالإنتقال إلى هذه المعاني؟
قلت: هذا أمر مركوز في أذهانهم، وإن لم يذكره بالتفصيل، ويعلمون أنّ هذا المجعول شرعاً إظهار عبودية منهم إلى خالقهم، وليس هذا أمراً خفيّاً، ألا ترى عبدة النار والأوثان يظهرون الخضوع لآلهتهم، ويتقرّبون إليهم ممّا يزعمون أنّه تذلّل وتخضّع، فعلى القول بالحرمة الذاتية إن أتت الحائض بالصلاة مع قصد حقيقتها ولو بالإجمال(١) ، من غير نظر إلى أنّها من الدين، فعلت محرماً من جهة واحدة، وإن قصدت مع ذلك التشريع فعلت محرّماً من وجهين، ولو فرض أنّها قصدت ذوات الأفعال لم تفعل محرّماً، بل لو أتت بها في غير حال الحيض أشكل الحكم بكونها مسقطة للأمر.
إذا عرفت ذلك فنقول: حجّة القائلين بالحرمة التشريعية امور:
الأوّل: الأصل، والثاني: ما روي عن علي الرضا سلام اللّه عليه وعلى آبائه
____________________
(١) بالاحتمال (خ) في نسخة طهران.
وأبنائه: إذا حاضت المرأة فلا تصوم ولا تصلّي، لأنّها في حدّ نجاسة، وأحبّ اللّه أن لا يعبد إلاّ طاهراً، ولأنّه لا صوم لمن لا صلاة له(١) بناءً على أنّ المراد من أحبّ حصر العبادة في حال الطهارة حصر حبّ العبادة بحال الطهارة، وقد شاع استعمال ذلك بهذا المعنى، فانّ تعليل ترك الصلاة في حال الحيض بانتفاء الحبّ يكشف عن كون النهي إرشادياً إلى عدم الأمر، ويترتّب عليه الحرمة التشريعيّة، ولو كان لها جهة مبغوضية كان التعليل بها أولى.
ودعوى أنّ ظاهر التعليل محبوبية ترك العبادة، ويلزمها مبغوضية الفعل، ضرورة أنّ المراد منه ليس رجحان الترك الجامع لمرجوحيّة الفعل.
مدفوعة بما عرفت من أنّ الظاهر من أمثال هذه العبارة حصر الحبّ لا المحبوب، مضافاً إلى أنّ قولهعليهالسلام : ولأنّه لا صوم لمن لا صلاة له(٢) ظاهر في أنّ المراد من النهي عن الصوم هو الإرشاد إلى نفي المشروعيّة، وأنّه المقصود من التعليل السابق أيضاً، على أنّ مبغوضية العبادة لا يلازم مبغوضيّة ذات الفعل، فتأمّل، فانّه ينافي بعض ما مرّ في تحديد النزاع.
وممّا يؤيد كون المراد من التعليل نفي المشروعيّة أنّ الظاهر عدم الإشكال في أنّ الصلاة في حال الجنابة وغيرها من الأحداث لا تكون محرّمة، مع أنّ الجنابة كالحيض، ولذا يرتفعان بغسل واحد، بل في كثير من الأخبار دلالة على أنّ الجنابة والحيض نوعان من جنس واحد.
الثالث: ظهور الإتفاق من كلمات الأصحاب على حسن الاحتياط على المضطربة وغيرها ممّن اشتبهت حالها ودمها بغير الحيض، بل المتتبع المتأمّل يجد أنّ ذلك عندهم من الواضحات التي لا يعتريه شكّ وارتياب، ولو كان الأمر كما تخيّل
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب تحريم الصلاة والصيام ونحوهما على الحائض من أبواب الحيض، ح ٢، ج ٢، ص ٥٨٦.
(٢) وسائل الشيعة: ب تحريم الصلاة والصيام ونحوهما على الحائض ح ٢، ج ٢، ص ٥٨٦.
من الحرمة الذاتيّة لما كان كذلك وجه لو لم يكن الاحتياط في ترك العبادة بناء على خيرة جماعة(١) من تقديم جانب الحرمة عند دوران الأمر بين المحذورين، هذا ما يمكن التمسّك به لمنع الحرمة الذاتيّة.
ويندفع الوجه الأول بل الثاني، أولاً: بظهور معاقد الإجتماعات وكلمات الأصحاب في الحرمة الذاتيّة، خصوصاً بعد عدّ الصلاة في طي جملة من المحرّمات الذاتيّة كمس كتابة القرآن وقراءة العزائم. وثانياً: بأخبار كثيرة، لإشتمالها على ألفاظ ظاهرة في الحرمة الذاتيّة كلفظ « لا يجوز » و « حرمت » و « لا يحلّ »، وحملها على مجرد الرخصة في الترك لورودها في مقام توهّم اللزوم، كما أنّ الأمر الوارد في مقام توهّم الحصر يحمل على الإباحة، بعيد في الغاية كما لا يخفى، كحملها على الحرمة التشريعيّة، إذ نفي المشروعية لا دليل عليه غير هذه الأخبار، وإرادة الحرمة التشريعيّة متوقفة على علم السامع بعدم المشروعيّة.
ودعوى أنّ ظاهر مورد النهي هو الصلاة بقصد القربة، لانصرافه إلى ما كانت تفعل قبل الحيض كما كانت تفعل.
مدفوعة أولاً بالمنع، وثانياً أنّ ذلك إن اريد به حقيقته التي لا(٢) يتحقق الاعتقاد مع وجود الأمر فلا ربط له بالتشريع، وإن اريد منه الأعمّ من القصد الصوري، فمدفوعة بأنّ حملها على ذلك لا يتاتّى إلاّ مع العلم بعدم المشروعيّة من غير هذه النواهي، والظاهر خلافه.
وممّا يؤكد الحرمة الذاتيّة قولهعليهالسلام في صحيحة خلف بن حمّاد: فلتتق اللّه، فإن كان عن دم الحيض فلتمسك عن الصلاة(٣) إذ من الواضح أنّ التي اشتبه دمها لا تصلّي تشريعاً، بل هي إمّا تفعل بقصد المشروعيّة جزماً أو إحتمالاً، بل
____________________
(١) الذكرى: في مبحث الحيض ص ٢٩، س ٢٦، والرياض: في احكام الحيض ج ١، ص ٤٢، س ١٦.
(٢) قد (خ) في نسخة طهران.
(٣) وسائل الشيعة: ب ما يعرف به دم الحيض من دم العذرة قطعة من ح ١، ج ٢، ص ٥٣٥.
ظاهر الخبر هو أنّ البناء على الأصل في الشبهة الموضوعيّة في دم الحيض غير جائز، ويجب الفحص والبحث عن حال الدم، بل استظهر بعضهم(١) بطلان الاحتياط أيضاً فضلاً عن العمل بالأصل.
وأمّا الثالث، فمع عدم منافاته لذلك، إمّا لكون فعل الصلاة في حال الطهارة أهم من تركها في حال الحيض، أو لكون القصد إلى عنوان العبادة معلّقاً على كونها طاهرة، كما أن القصد إلى الصلاة الواقعيّة ممّن يصلّي إلى الجهات الأربع في كلّ جهة معلّق على كون تلك الجهة قبلة، فتأمّل، فانّ تصوّر التعليق هنا لا يخلو عن منع أو صعوبة بأنّ الإتفاق ممنوع، وعن بعض(٢) المنع عن الاحتياط، والتصريح بالحرمة الذاتيّة، وأنّ الاحتياط بالفعل معارض بمثله.
وممّا يؤيّد الحرمة الذاتية تسمية الإستظهار في كثير من الأخبار احتياطا، ولو كانت(٣) الحرمة تشريعيّة لم يتصوّر كون الاستظهار بترك العبادة كما هو صريح الأخبار احتياطاً، وأيضاً لو كانت(٤) الحرمة تشريعيّة لكان مقتضى القاعدة - من حيث العلم بوجود أيّام الطهر في أيّام الدم لمن استمرّ دمها على بعض الوجوه المقرّرة في محلّه - هو الاحتياط بفعل الصلاة في جميع أيّام الدم ولم يكن للرجوع إلى التميّز وعادة نسوة أهلها والروايات وجهٍ جلي.
ودعوى كون الاحتياط بفعل الصلاة وتروك الحائض حرجاً، ممنوعة.
وأمّا ما ذكر من أنّ مقتضى الحرمة الذاتية نظراً إلى تعليل رواية العلل حرمة الصلاة على الجنب، بل في غير حال الطهارة، ففيه أنّ ذلك لا مانع منه، وأيّ اتّفاق علم قيامه على خلافه، بل بعض الأخبار كالنص في حرمة الصلاة بغير وضوء، كقولهعليهالسلام في رواية مسعدة بن صدقة في جواب من سأله عن الصلاة مع
____________________
(١) الحدائق: في رجوع المبتدئة الى الروايات ووقت تحيّض المضطربة ج ٣، ص ٢٠٥ و ٢٣٦.
(٢) الحدائق: في رجوع المبتدئة الى الروايات ج ٣، ص ٢٠٥.
(٣) و (٤) في النسخة « كان » بدل « كانت »، والصحيح ما اثبتناه.
قوم ناصبيّة بغير وضوء: سبحان اللّه فما يخاف من صلّى على غير وضوء أنّ تأخذه الأرض خسفاً(١) ، بل مقتضى ظاهر عنوان الباب في الوسائل أنّه اختيار حرمة الصلاة بغير وضوء إذا كان كذلك كانت صلاة الحائض والجنب أولى بذلك كما لا يخفى، هذا.
ولكنّ الإنصاف أنّ المسألة من المشكلات، فانّ حمل كلمات الأصحاب على الحرمة التشريعيّة ليس بكلّ البعد، بل هو مقتضى الجمع بين ما عرفت من الفتوى بحسن الاحتياط في موارد اشتباه الدم، خصوصاً مع إرسالهم إيّاه إرسال المسلّمات، وتأيّده بدعوى الاتّفاق عليه، وضعف ما مرّ من التوجهين، وظهور رواية العلل(٢) في الحرمة التشريعيّة، وإمكان حمل الأخبار الناهيّة على الحرمة التشريعيّة بدعوى معلوميّة كون الصلاة وفروعه عن الحائض، خصوصاً في زمن صدور تلك الأخبار، فانّها مرويّة عن الصادقين عليهما وعلى آبائهما الطاهرين وأبنائهما الطيبين أفضل الصلاة والسلام، وأمّا رواية خلف بن حمّاد(٣) فيمكن حمله أيضاً على الإمساك عن الصلاة بقصد المشروعيّة لعدم المبالاة في تبيّن حال الدم والبناء على الطهارة من غير استناد إلى أمر معتبر من أصل أو أمارة معتبرة، وأمّا رواية مسعدة بن صدقة(٤) فلا تقبل الحمل على شيء، فالاقوى مع قطع النظر عن رواية مسعدة بن صدقة هو التشريعيّة، ومع صحّة سندها فالأقوى الحرمة الذاتيّة كما لا يخفى، واللّه العالم بحقيقة الحال.
وأمّا الطواف فيحرم عليها لتوقّفه على الدخول في المسجد الحرام، وسيأتي، مع أنّ الواجب منه لا يصحّ منها لتوقّفه على الطهارة، ولو طافت ندباً فتبيّن أنّها حائض ففي صحّة الطواف وعدمه وجهان، من أنّه لكونه عن الدخول في المسجد منهيّاً عنه في الواقع فلا يصحّ، ومن أنّ مفهوم الطواف أعمّ من الكون في المسجد من وجه، وإن
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة ح ١، ج ١، ص ٢٥٨.
(٢) علل الشرائع: العلة التي من اجلها تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة ح ١ و ٢، ص ٢٩٣ و ٢٩٤.
(٣) وسائل الشيعة: ب ما يعرف به دم الحيض من دم العذرة ح ١، ج ٢، ص ٥٣٥.
(٤) وسائل الشيعة: ب أبواب الوضوء ح ١، ج ١، ص ٢٥٧.
كان أخصّ من الصلاة بحسب الخارج، فالنهي عنه لمزاحمة الاتّحاد مع الكون في المسجد، والفرض أنّه لأجل الجهل بالحيض، مرتفع فيصحّ، وهو الأقوى، وله نظائر كثيرة، والتحقيق في الاصول.
وأمّا مسّ كتابة القرآن فالمشهور شهرة عظيمة على حرمته وقد حكي الاتفاق عليه عن جماعة(١) ، ويلحق بالقرآن الأسماء المحترمة كأسماء اللّه وأسماء الأنبياء والأوصياء سلام اللّه على نبيّنا وآله وعليهم أجمعين.
وعن ابن الجنيد(٢) أنّه يكره مسّ الحائض للقرآن، ويحتمل أن يريد من الكراهة الحرمة، وليس ذلك بعيد.
وعن سلاّر(٣) استحباب ترك المسّ، وهو أيضاً محجوج بما مرّ من الإجماعات المحكيّة(٤) .
قوله «قدسسره »: « ويكره لها حمل المصحف ولمس هامشه ».
وبين سطوره كما هو المشهور، بل عن المعتبر(٥) دعوى الاجماع عليه، وعن المرتضى(٦) حرمة حمل المصحف ولمس هامشة.
____________________
(١) منتهى المطلب: في تحريم مس كتابة القرآن على الحائض ج ١، ص ١١٠، س ٣١، وجامع المقاصد: في احكام الحيض وغسله ج ١، ص ٣١٧.
(٢) مختلف الشيعة: في أحكام الحيض ج ١، ص ٣٦، س ١٩.
(٣) المراسم: في حكم الحيض وغسله ص ٤٣.
(٤) منتهى المطلب: في تحريم مس كتابة القرآن على الحائض ج ١، ص ١١٠، س ٣١، وجامع المقاصد: في احكام الحيض وغسله ج ١، ص ٣١٧.
(٥) المعتبر: في احكام الحيض ج ١، ص ٢٣٤.
(٦) نقله عنه في المعتبر: في احكام الحيض ج ١، ص ٢٣٤.
قولهقدسسره : « ولو تطهّرت لم يرتفع حدثها ».
سواء كان التطهير بالغسل أو الوضوء أو غيرهما، وحكي الاتّفاق عليه عن جماعة(١) .
أقول: لا إشكال في أنّ حدث الحيض لا يرتفع ما دام الدم جارياً، وأمّا غيره كحدث الجنابة والمس والحدث الأصغر ففي ارتفاعه قبل انقطاع الدم إشكال.
والتحقيق: إنّا إن قلنا أنّ تداخل الأغسال عزيمة، لأنّ الأحداث الموجبة لها ترجع إلى حقيقة واحدة وأنّ الحدث الأصغر مرتبة ضعيفة من الحدث الأكبر، ولذا يرتفع بالغسل إذا تحقّق موجبه، ولو كان الغسل بغير الجنابة فلا ينبغي الإشكال حينئذٍ في أنّه لا يرتفع لها حدث، إذ لا يعقل الإرتفاع حال وجود الموجب، وكذا لا إشكال في ذلك إن قلنا: إنّ تخلّل الموجب بين أجزاء الغسل مبطل له، ولو كان موجباً لغسل آخر غير الذي اشتغل به، لأنّ حدث الحيض يراد آناً فآناً حتى في زمان النقاء المتخلّل بين الدمين، لأنّه في حكم الدم.
والحاصل أنّ الحيض شرعاً حدث دائم إلى زمان انقطاع الدم رأساً، وقد فرضنا أنّ تخلّل الحدث بين أجزاء الغسل مطلقاً مبطل له فكيف يصحّ الغسل ؟ وأمّا بناءً على كون التداخل رخصة وعدم كون تخلّل الحدث مانعاً عن الغسل مطلقاً، ففي ارتفاع الحدث لها مطلقاً إشكال. وعن المعتبر(٢) أنّه استدلّ لذلك بأنّ عليه الإجماع، وبأنّ الطهارة ضد الحيض. وعن المنتهى(٣) الاستدلال به بأنّ الحدث ملازم، وبطروّ المنع إلى المضادّة بين الطهارة عن سائر الأحداث، والحيض مع عدم البناء على اتّحاد حقيقة الأحداث، أو إبطال تخلّل موجب الغسل له ظاهر، كما أنّ ملازمة
____________________
(١) و (٢) المعتبر: في احكام الحيض ج ١، ص ٢٢١.
(٣) منتهى المطلب: في تحريم الطواف على الحائض ج ١، ص ١١٠، س ٢٥.
الحدث مع عدم البناء على أحد الوجهين ظاهر المنع.
وأمّا الإجماع(١) فكشفه عن رضا الحجّة مع الظنّ بكون سند المجمعين بعض هذه الوجوه مشكل.
اللّهم [ إلاّ ] أن يقال: إنّ ظاهر دعوى المحقّق(٢) الإجماع هو الإجماع بطريقة القدماء.
وقد يستدلّ أيضاً بمصحّحة الكاهلي عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل، تغتسل أو لا تغتسل؟ قالعليهالسلام : قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل(٣) .
ولعلّ بناء ذلك على أنّ المراد من النهي نفي المشروعيّة، وأنّ السؤال عن ذلك، وعليه فمعنى التعليل: أنّ غسل الجنابة لكون شرعيته لأجل التمكّن من الصلاة الممتنع صدورها عن الحائض لا يكون مشروعاً لها.
ويحتمل أن يكون السؤال عن وجوب الغسل، ويكون المراد من الجواب نفيه معلّلاً بأنّ وجوب الغسل لمّا كان لأجل الصلاة ارتفع وجوبه بارتفاع وجوب الصلاة لوجود المفسد.
ولكنّ الإنصاف أنّ دعوى ظهور السؤال في أصل المشروعيّة لا يخلو عن قوّة، وأمّا احتمال أن يكون السؤال عن مشروعية الغسل لأجل الصلاة فضعيف في الغاية.
وقد يستدلّ أيضاً برواية سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّهعليهالسلام : المرأة ترى الدم وهي جنب أتغتسل من الجنابة، أو غسل الجنابة والحيض واحد؟ فقال: قد أتاها ما هو أعظم من ذلك. بناءً على أنّ السؤال عن مشروعيّة غسل الجنابة لها حال الحيض، فحاصل السؤال أنّه هل يجوز لها غسل الجنابة أو يجب
____________________
(١) منتهى المطلب: في تحريم الطواف على الحائض ج ١، ص ١١٠، س ٢٥.
(٢) المعتبر: في احكام الحيض ج ١، ص ٢٢١.
(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب الحيض ح ١، ج ٢، ص ٥٦٥.
عليها التأخير إلى انقطاع الدم فتغتسل غسلاً واحداً للجنابة والحيض؟ ويكون محصّل الجواب نفي المشروعيّة بسبب وجود ما هو أعظم من الجنابة الموجب لإنتفاء الغرض المقصود بالأصالة من مشروعيّة غسل الجنابة، وهو التمكّن من الاشتغال بالصلاة.
وفيه: أنّ السؤال يحتمل أن يكون عن وجوب الغسل من الجنابة بتخيّل فوريّة وجوب رفع الجنابة، فحاصله أنّه هل يجب عليها أن تغتسل من الجنابة حال الحيض أو لا يجب عليها إلاّ غسل واحد لهما ؟
ولكنّ الإنصاف أنّ السؤال لا يخلو عن ظهور في الاستفهام عن المشروعيّة، خصوصاً بملاحظة قوله: « أو غسل الجنابة والحيض واحد » فانّه ظاهر في أنّ غسل الجنابة والحيض واحد في أصل الشرع، فكأنّ السائل لمّا كان فارغاً عن وحدة غسل الجنابة والحيض على تقدير ترك الغسل إلى زمان انقطاع الدم، وكان متردّداً في أنّ التأخير الموجب لاتّحادهما لازم حتى لا يكون في أصل الشرع لهذه المرأة إلاّ غسل واحد أو لا يجب ذلك، سأل عن جواز الغسل في حال الحيض، وجعل الوحدة في أصل الشرع الذي هو ملزوم وجوب التأخير في نظره كناية عن لازمه. وأمّا حمل السؤال على أنّه هل يجب عليها غسلان ولو مع التأخير إلى انقطاع الدم، فلا يلائم الجواب فتأمّل.
ويمكن الاستدلال أيضاً بصحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّه قال: سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة؟ قالعليهالسلام : غسل الجنابة والحيض واحد(١) بتقريب أن يقال: إنّ وحدة الغسلين شرعاً ملازم لوحدة موجبهما، وهو الحدث الحاصل من الجنابة والحيض.
وفيه: مع كون المراد الوحدة بحسب الشرع، بل يحتمل أن يكون المراد أنّ الذي يوجد من مثل هذه المرأة غسل واحد لهما، فحاصله أنّ الواجب عليها غسل واحد لهما، مع أنّ اتّحاد الغسلين لا يلزم منه اتّحاد الحدثين، بل يجوز أن يكونا
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب ان غسل الحيض كغسل الجنابة ح ٧، ج ٢، ص ٥٦٧.
مختلفين أحدهما قابل للرفع دون الآخر ويكون الإتيان بالغسل لرفع ما يقبل الارتفاع جائزاً، وعلى هذا فيمكن الاستدلال بالخبر على خلاف المدّعى، ولكنّه ضعيف، فانّ عدم الوجوب أعمّ من الجواز.
وكيف كان ففي الخبرين السابقين بضميمة الإجماع المتقدّم غنى إن شاء اللّه تعالى.
ولكن [ لا تخلو ] المسألة من إشكال، لمعارضة الخبرين(١) لعموم آية غسل الجنب(٢) .
إلاّ أن يقال: إنّ متعلّق الأمر هو التطهّر والشكّ في محل الكلام في أنّ الغسل يطهّر أم لا؟ اللّهم إلاّ أن يقال: إنّ التطهّر عرفاً هو الغسل إطلاق الأثر على المؤثر.
ودعوى أنّه على تقدير التسليم لا يستلزم حصول الطهارة من الجنابة، لأنّ الأمر بالغسل أعمّ.
مدفوعة بأنّ الغرض منه ليس إلاّ ذلك، فمقتضى الأمر بالغسل ترتّبه عليه، فتأمّل.
وبموثقة عمّار عن أبي عبد اللّهعليهالسلام قال: سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسل قال: إن شاءت أن تغتسل فعلت، وإن لم تغتسل فليس عليها شيء، فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للجنابة والحيض(٣) فانّ صراحتها في جواز الغسل حال الحيض وظهور الخبرين السابقين(٤) مع إمكان منعه كما عرفت معيّن للعمل بها لولا الإجماع وإعراض الأصحاب عنها مع صراحتها وقوّة سندها.
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب ان الحائض لا يرتفع لها حدث ح ١، ج ٢، ص ٥٦٥، وب ان غسل الحيض كغسل الجنابة ح ٧، ج ٢، ص ٥٦٧.
(٢) المائدة : ٦.
(٣) وسائل الشيعة: ب ان الحائض لا يرتفع لها حدث ح ٤، ج ٢، ص ٥٦٦.
(٤) وسائل الشيعة: ان الحائض لا يرتفع لها حدث ح ١، ج ٢، ص ٥٦٥ ، وب ان غسل الحيض كغسل الجنابة ح ٧، ج ٢، ص ٥٦٧.
وكيف كان فالعمل على ما عليه الأصحاب إن لم يكن متعيّناً فهو أحوط.
قولهقدسسره : « الثاني: لا يصحّ منها الصوم ».
أقول: فيحرم عليها تشريعاً، والكلام في حرمته ذاتاً ما تقدّم في حرمة الصلاة عليها.
قولهقدسسره : « لا يجوز لها الجلوس في المسجد، ويكره الجواز فيه ».
أقول: هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال في المنتهى(١) أنّه مذهب عامّة أهل العلم انتهى.
والظاهر أنّ المراد من الجلوس المكث، ويحتمل أن يكون المراد منه مطلق الكون المقابل للجواز، فيشمل التردّد في جوانب المسجد، وهو قوي، لظاهر قولهعليهالسلام في صحيحة زرارة: الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلاّ مجازين(٢) لعدم صدق الاجتياز على التردّد في جوانب المسجد.
ومن ذلك يظهر عدم جواز الدخول في مسجد له باب واحد والخروج منه، إذ الاجتياز هو الدخول من باب والخروج من باب آخر.
ولو دخلت في المسجد بقصد التمشّي ثمّ اتفق خروجها من باب آخر فالظاهر أنّها فعلت محرّماً، لأنّ الظاهر أنّ المستثنى هو الكون في المسجد بعنوان الاجتياز، لا مطلق ما يصدق عليه الاجتياز، ولو كان اتّفاقياً.
____________________
(١) منتهى المطلب: في تحريم لبث الحائض في المساجد ج ١، ص ١١٠، س ٥.
(٢) وسائل الشيعة: ب جواز مرور الجنب والحائض في المساجد ح ١٠، ج ١، ص ٤٨٦.
و الظاهر أنّ جواز الاجتياز في غير المسجدين ، و أمّا فيهما فلا يجوز، ولا خلاف فيه ظاهراً كما عن المدارك(١) وشرح المفاتيح(٢) لقولهعليهالسلام في حسنة محمد بن مسلم: ولا يقربان المسجدين الحرامين(٣) وللإجماع عليه في الجنب، واشتراكهما معه في كثير من الأحكام، وكونها أسوأ حالاً منه، ولعلّ إطلاق بعض الأخبار، كإطلاق كثير من الفتاوى، منزّل على غيرهما، لأنّه الغالب، أو للإحالة على تصريحهم به في الجنب.
ثمّ إنّه لا إشكال في الجملة في أنّ من أجنب في المسجدين يجب عليه التيمّم للخروج، وهل يجب للحائض إن فاجأها الحيض؟ فيهما وجهان، من أنّ التيمّم لا يفسدها، لما مرّ من أنّ حدثها لا يرتفع، ولأنّه مستلزم للمكث الزائد، ومن التصريح به في بعض الأخبار، أقربهما الأوّل، لمخالفة الخبر للقاعدة، مع ضعفه، وانتفاء العمل به على وجه يجبر به ضعف الإسناد.
نعم لا بأس بالقول باستحبابه، كما عن المصنّف في المعتبر(٤) خروجاً عن شبهة وجوبه، فتأمّل فأنّ هذا أيضاً ينافي بعض ما مرّ، فتأمّل. وهل يكره الجواز في غير المسجدين، أو باقٍ على إباحة؟ وجهان أقواهما الأول، ويكفي فيه مع دعوى الشيخ في الخلاف(٥) الإجماع عليه، ولمناسبته لتعظيم المسجد قول المصنّفقدسسره : ويكره الجواز فيه كما عن الصدوق(٦) ، والشيخ(٧) ، والعلاّمة(٨) ، والشهيد(٩) ،
____________________
(١) مدارك الاحكام: في احكام الحائض ج ١، ص ٣٤٧.
(٢) لم نعثر عليه.
(٣) وسائل الشيعة: ب جواز مرور الجنب والحائض في المساجد ح ١٧، ج ١، ص ٤٨٨.
(٤) المعتبر: في احكام الحيض ج ١، ص ٢٢٣.
(٥) و (٧) الخلاف: في عدم جواز المقام واللبث للجنب في المساجد ج ١، ص ١٨٠.
(٦) من لا يحضره الفقيه: صفة غسل الجنابة ح ١٩١، ج ١، ص ٨٧.
(٨) قواعد الاحكام: في احكام الحائض ج ١، ص ١٥ ، س ١٨.
(٩) اللمعة الدمشقية: في المكروهات على الجنب ج ١، ص ٣٥١.
فالتوقّف فيه كما عن بعض(١) ليس في محلّه.
ثمّ إنّه لا إشكال في التي يحرم عليها وضع شيء في المسجد، كما أنّه يجوز الأخذ منه لصحيحة عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّهعليهالسلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه. قال: نعم، ولكن لا يضعان فيه شيئاً(٢) قال زرارة: قلت : فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه؟ قالعليهالسلام : لأنّهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلاّ منه ويقدران على وضع ما بيديهما في غيره(٣) .
وهل المراد من الوضع مطلقه، أو ما يستلزم الدخول؟ حكي عن بعض(٤) الأوّل، وقوّى الشارح الثاني وجعل الأول أجود، وحكي ذلك عن ابن فهد(٥) أيضاً، وقال بعض من قارب عصرنا(٦) : إنّ حرمة الوضع ليست لكونه وضعاً بل لحرمة الدخول للوضع، وعليه فيكون المراد من الأخذ الدخول للأخذ، فيكون المستثنى من الدخول أمرين: الدخول للإجتياز وللأخذ، ويكون حرمة الدخول للوضع على الأصل، وهذا وإن لم يكن بعيداً إلاّ أنّه مخالف لظاهر الأخبار وفتاوى الأصحاب، فانّ الظاهر منها أنّ الوضع هو المحرّم كتسليم حرمة الوضع لذاته ودعوى انصرافه الى المستلزم للدخول، نعم لا يبعد دعوى تبادر ما يستلزم دخول اليد أو غيرها، فالوضع بآلة على وجه يكون تمام الجسد خارجاً من المسجد لا يكون محرّماً، والأحوط تركه.
ثم إن قلنا انّ الوضع الذي لا يستلزم دخول المسجد محرّم، فهل الدخول للأخذ جائز؟ وجهان، من أنّ المحرّم لكونه مقدّمة لمباح لا يصير مباحاً، ومن أنّ الظاهر
____________________
(١) المعتبر: في احكام الحيض ج ١، ص ٢٢٢.
(٢ و ٣) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب الجنابة ج ١ و ٢ ، ج ١، ص ٤٩١.
(٤) تحرير الاحكام: في احكام الحيض والحائض ج ١، ص ١٥، س ٩، والتنقيح الرائع: في احكام الحيض ج ١، ص ٩٦.
(٥) المقتصر: في الطهارة المائية ص ٤٩.
(٦) جواهر الكلام: في حرمة وضع شيء في المسجد للجنب ج ٣، ص ٥٤.
الرخصة في الأخذ على وجهٍ يستلزم ذلك لبعد تخصيصه، بغير ذلك.
ثم إنّه ألحق جماعة(١) بالمسجد في أحكامه السابقة الضرائح المقدّسة والمشاهد المشرّفة، وهو لا يخلو من قوّة، لقوة كون مناط الحكم شرف القبة ، و عليه فإلحاقها بالحرمين أقوى ، و يؤيّده ما دلّ من منع دخول الجنب [ عليهم ]عليهمالسلام أحياء(٢) ، وحرمتهم أمواتاً كحرمتهم أحياء.
قولهقدسسره : « ولا يجوز لها قراءة شيء من العزائم ».
أقول: الظاهر أنّ هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، وفي كراهة ما عدا ذلك مطلقاً، أو كراهة ما زاد على السبع أو السبعين، أو حرمة ما زاد عليهما؛ وجوه، أقواهما الأول، لما روي عنهصلىاللهعليهوآله السلام: لا يقرأ الجنب والحائض شيئاً من القرآن(٣) .
قولهقدسسره : « وتسجد لو تليت السجدة، وكذا لو أسمعت »(٤) .
أقول: الأشهر بل المشهور ظاهراً جواز السجود للحائض، إذا وقع منها ما يوجب السجدة لغيرها، بل الظاهر وجوبها عليها لإطلاق ما دلّ على سببية سببها في
____________________
(١) جواهر الكلام: في كراهة الاجتياز في المسجد الحائض ج ٣، ص ٢٢١.
(٢) وسائل الشيعة: ب كراهة دخول الجنب بيوت النبي صلى الله عليه وآله والائمة (ع) ج ١، ص ٤٨٩ و ٤٩٠، انظر الباب.
(٣) سنن البيهقي: ذكر الحديث الذي ورد في نهي الحائض عن قراءة القرآن ج ١، ص ٨٩.
(٤) كذا في النسخة الخطية، وفي النسخة المطبوعة لشرائع الإسلام هكذا: وتسجد لو تلت السجدة وكذا لو استمعت.
الوجوب وعدم ما يصحّ(١) لإشتراط الطهارة فيها، ولقولهعليهالسلام في صحيحة أبي عبيدة بعد السؤال عن سماع الطامث السجدة: إن كانت من العزائم فتسجد إذا سمعتها(٢) ، وقول الصادقعليهالسلام في موثّقة أبي بصير: الحائض تسجد إذا سمعت السجدة(٣) ، ولقولهعليهالسلام في مضمرة أبي بصير: إذا قرئ شيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد، وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنباً، وإن كانت المرأة لا تصلّي(٤) خلافاً للمفيد في المقنعة(٥) ، والشيخ في التهذيب(٦) ، والاستبصار(٧) ، والنهاية(٨) ، والوسيلة(٩) ، والمهذب(١٠) ، لاعتبارهم في السجود الطهارة، بل عن التهذيب(١١) لا يجوز السجود إلاّ لطاهر من النجاسات بلا خلاف، ويستدلّ لهم أيضاً بما عن السرائر، عن كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن غياث، عن جعفر، عن أبيهعليهماالسلام قال: لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة(١٢) . وبمصححة البصري عن الحائض تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة، قال: تقرأ ولا تسجد(١٣) .
____________________
(١) يصلح (خ) في نسخة طهران.
(٢) وسائل الشيعة: ب وجوب سجود الحائض اذا سمعت تلاوة العزيمة ح ١، ج ٢، ص ٥٨٤.
(٣) وسائل الشيعة: ب وجوب سجود الحائض اذا سمعت تلاوة العزيمة ح ٣، ج ٢، ص ٥٨٤.
(٤) وسائل الشيعة: ب وجوب سجود الحائض اذا سمعت تلاوة العزيمة ح ٢، ج ٢، ص ٥٨٤.
(٥) المقنعة : باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ص ٥٢.
(٦) التهذيب: في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ح ٤٢، ج ١، ص ١٢٩.
(٧) الاستبصار: باب الجنب والحائض يقرآن القرآن ح ٥، ج ١، ص ١١٥.
(٨) النهاية: باب الجنابة واحكامها وكيفية الطهارة منها ص ٢٠.
(٩) الوسيلة: في احكام الجنابة ص ٥٥.
(١٠)المهذب: باب الجنابة ج ١، ص ٣٤.
(١١) التهذيب: في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ح ٤٢، ج ١، ص ١٢٩.
(١٢) مستطرفات السرائر: ح ٤٧، ص ١٠٥.
(١٣) التهذيب: باب كيفية الصلاة وصفتها والمنسوب من ذلك ح ٢٨، ج ٢، ص ٢٩٢.
والجواب عن الأوّل منع الاشتراط، لعدم الدليل، بل الظاهر القطع بعدمه لرواية(١) الاشتراط في مطلق السجود، وعن الأخيرين(٢) بمعارضتها بما سبق، فيجب حملها على التقية، مع أنّ الأخير يمكن ادّعاه ظهورها في عدم الوجوب، ولا بأس به في السماع من غير إصغاء، كما هو ظاهر مورد الخبر، بل وكذا الأوّل، إذ الظاهر أنّ النهي عن القضاء لنفي الوجوب، إذ الظاهر أنّ القضاء لا يكون محرّماً ذاتياً، وإرادة الحرمة التشريعيّة من هذا النهي لا يخلو عن إشكال، إذ هو متوقّف على العلم بعدم ثبوته شرعاً، ولا طريق إليه إلاّ هذه الأخبار، على أنّه يكفي في عدم الاستدلال احتمال عدم علم المخاطب بالخبر، لعدم المشروعيّة، فتأمّل.
ثمّ إنّ ظاهر العبارة عدم الوجوب عليها إذا سمعت من غير إصغاء، وذلك مبني على منع سببية السماع بدون إصغاء له، وسيأتي الكلام فيه في محلّه إن شاء اللّه تعالى.
قولهقدسسره : « يحرم على زوجها وطؤها ».
أقول: لا يجوز على زوجها وطئها قبلاً حتى تطهر بالإجماع، بل لضرورة الإسلام، ولذا صرح بعض(٣) عن غير واحد بكفر مستحلّه، وذلك بناءً على أنّ منكر الضروري ولو كان لشبهة يحكم بكفره واضح، وأمّا على القول بعدم كون الإنكار لشبهة مكفّراً، ففي إطلاق الحكم إشكال، لأنّ إحتمال الشبهة في هذا الحكم
____________________
(١) التهذيب: في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ح ٤٢ و ٤٣، ج ١، ص ١٢٩.
(٢) وسائل الشيعة: مستطرفات السرائر: ح ٤٧، ص ١٠٥، والوسائل: ب وجوب سجود الحائض اذا سمعت تلاوة العزيمة ح ٤، ج ٢، ص ٥٨٤.
(٣) تذكرة الفقهاء: في الحيض واحكامه ج ١، ص ٢٨، س ٥، وجامع المقاصد: في احكام الحيض وغسله ج ١، ص ٣٢٠.
خصوصاً لعوام الناس متطرّق، وليس ذلك كوجوب الصلاة بحيث يعرف كلّ أحد أنّه من دين الإسلام.
وكيف كان فلا إشكال في أنّ فاعله عالماً بالحكم عاصٍ يستحقّ التعزير الموكول حدّه إلى الحاكم، وفي بعض الأخبار تحديده بربع حدّ الزاني، وعن تفسير القمي(١) عن الصادقعليهالسلام تحديده بالربع في أوائل الحيض، وبالثمن في أواخره.
وأمّا فسقه فقد نفى عنه الإشكال أيضاً بعض، وربما يومي إليه قولهعليهالسلام في رواية الفضل الهاشمي بعد السؤال عن أدبه: نعم عليه خمسة وعشرون سوطاً، ربع حدّ الزاني، وهو صاغر، لأنّه أتى سفاحاً(٢) فانّ في التعبير عنه بالصاغر إشارة إلى ذلك، وكما يحرم على الزوج الوطء كذا يحرم على الزوجة تمكينها، فيجب عليها الإمتناع، والظاهر أنّه أيضاً إجماعي، لإرسالهم إيّاه إرسال المسلّمات.
ثمّ إنّه لو اشتبه الحيض، بأن كانت المرأة متحيرة ، فسياتي حكمها، وبدونه تعمل بما يقتضيه الأصل، وإن كان الترك أولى، وعن العلاّمة(٣) والشهيدين(٤) إيجاب الاحتياط تغليباً لجانب الحرمة على المباح، وفيه نظر.
ثمّ إنّها لو ادّعت الحيض صدقت، لقوله تعالى: (ولا يحل لهنّ أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهن)(٥) بناءً على أنّ وجوب الإخبار مع عدم إفادته العلم يستلزم وجوب القبول، وإلاّ لغى إيجاب الاخبار المقصود منه ثبوت الخيرية به، إلاّ أن يدّعى إنصراف ما في الأرحام إلى الولد، أو منع كون الحيض الذي هو مناط للأحكام وجود الدم في الرحم، بل هو جريانه إلى خارجه، فلا يكون داخلاً في
____________________
(١) تفسير القمي: ج ١، ص ٧٣.
(٢) التهذيب: باب من الزيادات ح ٦، ج ١٠، ص ١٤٥.
(٣) تحرير الاحكام: في احكام الحيض والحائض ج ١، ص ١٥، س ٣٣.
(٤) البيان: في احكام الحائض ص ٢٠، س ١٠، والروض: في احكام الحيض ص ٧٧، س٧.
(٥) البقرة: ٢٢٨.
عموم ما في الأرحام، ولأنّه يتعسّر أو يتعذّر إقامة البيّنة عليه ولا يعلم إلاّ من قبلها، ولقولهعليهالسلام في صحيحة زرارة : العدة و الحيض إلى النساء(١) و في حسنة ذلك بزيادة قولهعليهالسلام : إذا ادّعت صدّقت(٢) ، وعن التذكرة(٣) ، وجامع المقاصد(٤) . والروض(٥) يفسد الحكم بعدم اتّهام الزوجة بتضييع حقّ الزوج، ولعلّه لإنصراف الصحيحة(٦) والحسنة(٧) إلى صورة عدم الإتّهام، ويؤيّده رواية السكوني عن الصادق، عن أبيه، أنّ أمير المؤمنينعليهالسلام قال في امرأة إدّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيضات: كلّفوا نسوة من بطانتهن أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت، فإن شهدن وإلاّ فهي كاذبة(٨) والمراد بالتهمة كون الشخص في ريبة منها، لسبب ما لاح من أمارات الكذب.
ولو ادّعت الطهارة من الحيض صدّقت أيضاً، لأنّها(٩) لا يعلم إلاّ من قبلها، ولظاهر الصحيحة السابقة، فانّ ظاهرها أنّ العدّة والحيض موكولان إلى النساء وجوداً وعدماً.
ولو اتّفق الحيض في أثناء الوطء وجب النزع على الزوج، ويكون كالمبتدء في جميع الأحكام، والزوجة كالزوج في مطاوعتها من حيث المعصية واستحقاق التعزير. وأمّا الكفارة فالظاهر عدم وجوبها على الزوجة مطلقاً.
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب وجوب الرجوع في العدة والحيض الى المرأة ح ٢، ج ٢، ص ٥٩٦.
(٢) وسائل الشيعة: ب وجوب الرجوع في العدة والحيض الى المرأة ح ١، ج ٢، ص ٥٩٦.
(٣) التذكرة: في احكام الحيض ج ١، ص ٢٨، س ٥.
(٤) جامع المقاصد: في الحيض وغسله ج ١، ص ٣٢٠.
(٥) الروض: في احكام الحيض ص ٧٧، س ٣.
(٦) و (٧) التهذيب: في الحيض والاستحاضة والنفاس ح ٦٦، ج ١، ص ٣٩٨.
(٨) وسائل الشيعة: ب وجوب الرجوع في العدة والحيض الى المرأة ح ٣، ج ٢، ص ٥٩٦.
(٩) كذا والصحيح: لأنّه.
قولهقدسسره : « فإن وطئ عامداً عالماً وجب عليه الكفارة، وقيل: لا يجب، والأوّل أحوط ».
أقول : اختلف الأصحاب في وجوب الكفارة و عدمه ، فعن الصدوقين(١) و المشايخ الثلاثة(٢) و ابن زهرة(٣) والقاضي(٤) وسلاّر(٥) وجماعة الأوّل، وعن الشيخ في الخلاف(٦) والسيدين في الانتصار(٧) والغنية(٨) وابن إدريس في السرائر(٩) الإجماع عليه، وعن جماعة(١٠) أنّه المشهور بين المتقدّمين، بل عن الروض(١١) أنّه المشهور مطلقاً. وعن الشيخ في النهاية(١٢) والمصنّف في المعتبر(١٣) والعلاّمة في المختلف(١٤) والشهيد في الذكرى(١٥) والبيان(١٦) والمحقّق الثاني في جامع المقاصد(١٧) .
____________________
(١) الجوامع الفقهية (المقنع): ص ٥، س ٢٣، لا توجد لدينا رسالة علي بن بابويه.
(٢) من لا يحضره الفقيه: في غسل الحيض والنفاس ح ٢٠٠، ج ١، ص ٩٦، والمقنعة: باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك ص ٥٥، والمبسوط: فصل في ذكر الحيض والاستحاضة ج ١، ص ٤١. (٣) الجوامع الفقهية (غنية النزوع): ص ٤٨٨، س ١٤.
(٤) المهذب: باب الحيض ج ١، ص ٣٥.
(٥) المراسم: حكم الحيض وغسله ص ٤٣.
(٦) الخلاف: كتاب الحيض والنفاس والاستحاضة ج ١، ص ٦٣.
(٧) الانتصار: في احكام الحيض ص ٣٣.
(٨) الجوامع الفقهية (غنية النزوع): ص ٤٨٨، س ١٤.
(٩) السرائر: احكام الدماء الثلاثة ج ١، ص ١٤٤.
(١٠ و ١١) الروض: في احكام الحيض ص ٧٧، س ٩.
(١٢) النهاية: في حكم الحائض، والمستحاضة والنفساء واغسالهن ص ٢٦.
(١٣) المعتبر: في احكام الحيض ج ١، ص ٢٣١.
(١٤) مختلف الشيعة: في غسل الحيض واحكامه ج ١، ص ٣٥، س ١٣.
(١٥) الذكرى: في احكام الحائض ص ٣٤، س ٣١. (١٦) البيان: في احكام الحائض ص ٢٠، س ٥.
(١٧) جامع المقاصد: في الحيض وغسله ج ١، ص ٣٢١.
والشهيد في الروض(١) الثاني، بل عليه أيضاً جماعة من متأخّرى المتاخرين(٢) ، بل حكي ذلك عن أكثرهم.
احتجّ الأوّلون، مضافاً إلى ما عرفت من الإجماعات المحكية المؤيّدة بالشهرة، بأخبار كثيرة، منها: رواية داود بن فرقد عن أبي عبد اللّهعليهالسلام في كفارة الطمث أنّه يتصدّق إذا كان في أوّله دينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار. قلت: وإن لم يكن عنده ما يكفّر ؟ قال: فليتصدّق على مسكين واحد، وإلاّ إستغفر اللّه تعالى و لا يعود ، فانّ الاستغفار توبة و كفارة لمن لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة(٣) ونحوها الرضوي(٤) .
ومنها: رواية ابن مسلم: عمّن أتى أهله وهي طامث، قال: يتصدّق بدينار ويستغفر اللّه(٥) .
ومنها: رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّهعليهالسلام : من أتى حائضاً فعليه نصف دينار يتصدّق به(٦) .
ومنها: مرسلة المقنع قال: روي أنّه إن جامعها في أوّل الحيض فعليه أن يتصدّق بدينار، وإن كان في نصفه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار(٧) .
ومنها: رواية محمد بن مسلم قال: سألت الباقرعليهالسلام عن الرجل أتى المرأة وهي حائض، قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار، وفي وسطه نصف
____________________
(١) الروض: في احكام الحيض ص ٧٧، س ١٥.
(٢) الذخيرة: في الحيض واحكامه ص ٧١، س ٢٧، وكشف اللثام: في احكام الحائض ج ١، ص ٩٤، س ٤١.
(٣) وسائل الشيعة: ب استحباب الكفارة لمن وطء في الحيض ح ١، ج ٢، ص ٥٧٤.
(٤) فقه الرضا: ص ٢٣٦.
(٥) وسائل الشيعة: ب استحباب الكفارة لمن وطء في الحيض ح ٣، ج ٢، ص ٥٧٥.
(٦) وسائل الشيعة: ب استحباب الكفارة لمن وطء في الحيض ح ٤، ج ٢، ص ٥٧٥.
(٧) الجوامع الفقهية (المقنع) : ص ٥، س ٢٣.
دينار. قلت : جعلت فداك يجب عليه شيء ؟ قال: نعم خمسة وعشرون سوطاً، ربع حدّ الزاني، لأنّه أتى سفاحاً(١) .
وعن القمي في تفسيره، عن الصادقعليهالسلام أنّه قال: من أتى امرأة في الفرج في أيّام حيض فعليه أن يتصدّق بدينار، وعليه ربع حّد الزاني خمسة وعشرون جلدة، وإن كان في آخر أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بنصف دينار ويضرب اثنى عشر جلدة ونصف(٢) .
وهذه الأخبار وإن اختلف إلاّ أنّ الرضوي(٣) ومرسلة المقنع(٤) ورواية داود(٥) لإنجبارها بما عرفت من الشهرة والإجماعات المحكية(٦) في الوجوب والمقدار وبسائر الأخبار في أصل الوجوب كافية في إثبات [ الوجوب ]. وأمّا غيرها فمطلقاتها يقيّد به ما كان مثل مرسلة القمي بما يرجع الى ما يطابق المرسلة السابقة.
وأجاب القائلون بالإستحباب: أمّا عن الإجماعات، فمع وهنها بمخالفة من عرفت، ومنهم بعض من ادّعى الإجماع، بأنّها تكشف عن صدور الأوامر الظاهرة في الوجوب، ولا تكشف عن أمر بمعنى الوجوب. وبعبارة اخرى: المظنون أنّ الاتّفاق إن كان واقعاً فهو ناشٍ عن الأخبار الظاهرة في الوجوب التي هي بأيدينا، وهي مع شهادة اختلافها على إرادة الاستحباب، إذ لا يكاد يمكن الجمع بينها، معارضة بأقوى منها دلالةً، كصحيحة العيص بن القاسم عن رجل واقع امرأته وهي
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب حكم وطئ الزوجة في الحيض ح ١، ج ١٨، ص ٥٨٦، ولكن جاء فيه (وفي استدباره) بدل (وسطه).
(٢) تفسير القمي: ج ١، ص ٧٣.
(٣) فقه الرضا: ص ٢٣٦.
(٤) الجوامع الفقهية (المقنع): ص ٥، س ٢٣.
(٥) وسائل الشيعة: ب استحباب الكفارة لمن وطء في الحيض ح ١، ج ٢، ص ٥٧٤.
(٦) الانتصار: في احكام الحيض ص ٣٣، والخلاف: كتاب الحيض والنفاس والاستحاضة ج ١، ص ٦٣، والجوامع الفقهية (غنية النزوع): ص ٤٨٨، س ١٤.
طامث، قال: لا يلتمس فعل ذلك، قد نهى اللّه عز وجلّ أن يقربها، قلت: فإن فعل أعليه كفارة ؟ قال: لا أعلم فيه شيئاً يستغفر اللّه(١) .
وموثقة زرارة عن الحائض يأتيها زوجها، قال: ليس عليه شيء، يستغفر اللّه ولا يعود(٢) .
ورواية ليث المرادي عن وقوع الرجل على امرأته و هي طامث خطأ ، قال : ليس عليه شيء ، قد عصى ربّه(٣) .
ورواية الحلبي في الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه ؟ قال: يتصدّق على مسكين بقدر شبعه(٤) .
وهذه الأخبار كما ترى كلّها صريحة في نفي الوجوب، وحملها على التقية لإشعار قولهعليهالسلام في بعضها: لا أعلم فيه شيئاً() مؤيّداً بكون عدم الوجوب مذهب كثير منهم كأبي حنيفة، يرد عليه أنّه معارض بمثله حتى في إشارة(٦) الأخبار، فانّ قول الراوي في بعض أخبار الوجوب: إنّ الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار(٧) يدلّ على أنّ الوجوب كان مذهباً لبعض العامّة، بل هذا يجعل قولهعليهالسلام : لا أعلم فيه شيئاً تعريضاً على القائلين بالوجوب، ولو بنى عليهم لذلك، مع أنّ الحمل على التقيّة بعد وجود الجمع بحسب الدلالة لا وجه له.
ولكنّ الإنصاف أنّ عمل القدماء إلاّ قليلا منهم بأخبار الوجوب، مع كون أخبار نفي الوجوب نصب أعينهم، خصوصاً مع ضعف الخبر الدال على ترتيب
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب عدم وجوب كفارة الوطئ في الحيض ح ١، ج ٢، ص ٥٧٦.
(٢) وسائل الشيعة: ب عدم وجوب كفارة الوطئ في الحيض ح ٢، ج ٢، ص ٥٧٦.
(٣) وسائل الشيعة: ب عدم وجوب كفارة الوطئ في الحيض ح ٣، ج ٢، ص ٥٧٦.
(٤) وسائل الشيعة: ب استحباب الكفارة لمن وطء في الحيض ح ٥، ج ٢، ص ٥٧٥.
(٥) وسائل الشيعة: ب عدم وجوب كفارة الوطئ في الحيض ح ١، ج ٢، ص ٥٧٦.
(٦) لسان (خ) في نسخة طهران.
(٧) وسائل الشيعة: ب استحباب الكفارة لمن وطء في الحيض ح ٢، ج ٢، ص ٥٧٥.
الكفارة على النهج المعروف، وقوّة سند الأخبار النافية، مضافاً إلى ما عرفت من الإجماعات المنقولة يوهن العمل بأخبار النفي، وحمل أخبار الوجوب على الإستحباب، فالاحتياط لا ينبغي تركه، وإن لم يبلغ حدّ الوجوب، لما عرفت وقرّر في محلّه، وأنّه لا ينبغي الرجوع إلى وجوه الترجيح مع فرض وجود الجمع القريب، وأنّ الإجماعات المنقولة ليس فيها كشف في محلّ الغرض.
قوله «قدسسره »: « والكفارة في أوّله دينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار ».
أقول: المعروف من مذهب القائلين بوجوب الكفّارة أنّها في أوّله دينار، وفي وسطه نصفه، وفي آخره ربعه، إلاّ أنّ المحكي عن المقنع(١) أنّه جعلها بالشبع مسكيناً، ونسب الأوّل إلى الرواية، والمحكي عن الفقيه(٢) عكس ذلك، بل عن السيدين(٣) دعوى الإجماع على كونها على الوجه المعروف، ولا إشكال أيضاً على القول بالإستحباب في رجحان هذا الوجه.
نعم يجب الحكم باستحباب غيره أيضاً ويكون الإختلاف بحسب مراتب الفضيلة، ولم أر في هذا المقام كلاماً، ولا يحضرني ما أرجع إليه، والظاهر أنّ التثليث في كلّ حيض بحسبه، فما كان ثلاثة أوّله يوم وهكذا، وما كان أربعة أوّله يوم وثلث، وما كان خمسة يوم وثلثا يوم، إلى غير ذلك. وعن سلاّر(٤) أنّه حدّد الوسط بما بين الخمسة إلى السبعة، فما كان الخامس داخلاً في الوسط كان ثلاثة أيّام، وإلاّ
____________________
(١) الجوامع الفقهية: (المقنع) : ص ٥، س ٢٣.
(٢) من لا يحضره الفقيه: في غسل الحيض والنفاس ح ٢٠٠، ج ١، ص ٩٦.
(٣) الانتصار: في احكام الحيض ص ٣٣، والجوامع الفقهية (غنية النزوع): ص ٤٨٨، س ١٤.
(٤) المراسم: في حكم الحيض وغسله ص ٤٤.
فهو يومان، وعلى الأوّل فالأوّل أربعة، وعلى الثاني خمسة، وأمّا الآخر على كلّ تقدير وذلك واضح، وعن الراوندي(١) اعتبار ذلك بالنسبة إلى أكثر الحيض، فالأوّل دائماً ثلاثة أيّام وثلث يوم.
ثمّ لا يخفى أنّ الوجهين مشتركان في أنّه لا يلزم في كلّ حيض اشتماله على الوسط والآخر، بل يجوز أن يكون الحيض أقلّ من الأوّل.
ثمّ إنّ مبنى الوجهين ظاهراً جعل التثليث بالنظر إلى أكثر الحيض، غير أنّه على الأخير حقيقي، وكيف كان فهما مخالفان للظاهر المتبادر من الأخبار، بل قد يقال بمخالفتهما لصريح الأخبار، فانّ في بعضها يجب في استقبال الحيض.
الاستحاضة وأحكامها
قولهقدسسره : « ولو تكرّر منه الوطء ».
أقول: إذا تكرر(٢) أنّ الغسل يوجب العفو عن الدم المتخلّل في أمامه والذي بعده مطلقاً، أو إلى زمان الإنقطاع.
ثمّ إعلم إنّ الدم المنقطع، إمّا أنّه حادث في غير وقت العبادة ومنقطع في غير وقته، أو حادث في غير وقت العبادة قبل فعلها ومنقطع في غير وقتها، كالدم المستمرّ من الفجر إلى قبل الزوال، وإمّا منقطع في وقت العبادة والإنقطاع في الوقت أيضاً، إمّا قبل الغسل أو بعده.
فنقول: أمّا القسم الأوّل فلا حكم للإنقطاع فيه، بناءً على اختصاص الغسل بالدم في الوقت، وأمّا على الحدثية المطلقة فيجب الغسل، لأنّ الإنقطاع لا يؤثّر في رفع أثر الدم، إلاّ أن يقال: إنّ بقاء القوّة في الوقت شرط في تأثير الدم السابق على الوقت في إيجابه الغسل، نظراً إلى أنّ مقتضى الأخبار وجوب الغسل على
_______________________
(١) فقه القرآن: في الحيض و الاستحاضة والنفاس ج ١، ص ٥٤.
(٢) إلى هنا آخر نسخة طهران، وما تبقى من الرسالة فهو من نسخة الكرباسي.
المستحاضة، فإذا زالت الإستحاضة ارتفع موضوع الحكم.
وفيه نظر يظهر وجهه فيما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.
وأمّا القسم الثاني فحكمه حكم الأوّل، إلاّ أنّه يشكل بأن الدم في الفرض حادث في الوقت وكان موجباً للغسل، و هو لاستمراره بعد الغسل لم يرتفع أثره، وانّما عفي عنه بالنسبة [ إلى ] الصلاة في ذلك الوقت، لأجل الاستمرار وعدم إمكان الرفع، فحيث ارتفع المانع، وجب الغسل لرفع الحدث.
ويمكن أن يدفع الإشكال بأنّ الدم في وقت عبادة ليس سبباً لعبادة وقت آخر في نفسه، وقد ارتفع حكمه بالنسبة إلى ما كان موجباً له.
مضافاً إلى قولهعليهالسلام في رواية الصحّاف: فلتغتسل ثمّ تحتشي وتستثفر وتصلّي الظهر والعصر، ثمّ لتنظر، فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ عند وقت كلّ صلاة(١) بناءً على أنّ الغسل المأمور به قبل الظهرين للإستحاضة، فانّه يدلّ على أنّ الإنقطاع بعد الصلاة لا يوجب الغسل بالنسبة إلى عبادة اخرى، وفيه تأمّل، والمسألة لا تخلو من إشكال وتأمّل.
وأمّا القسم الثالث وهو ما ينقطع قبل الغسل في الوقت، فالظاهر وجوب الغسل، لأنّ الإنقطاع لا يرفع الوجوب الثابت قبله، إلاّ أن يقال: نمنع سببية الدم الذي لم يستمرّ الى وقت الصلاة للغسل، فإن ثبت إجماع على السببية وإلاّ فإيجاب الغسل مشكل.
نعم عند القائل بالسببيّة المطلقة، والقائل بكون الدم في الوقت في الجملة حدث موجب للغسل لا إشكال في وجوب الغسل، إلاّ أن يقال: باعتبار بقاء القوّة في حال الصلاة عند هؤلاء أيضاً في تاثير الدم في الوقت أو مطلقاً في إيجاب الغسل، وسيأتي الكلام فيه.
وأمّا القسم الرابع: وهو المنقطع بعد الغسل، فالظاهر وجوب الغسل إذا كان
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب الاستحاضة أقسامها، من أبواب الإستحاضة، ح ٧، ج ٢، ص ٦٠٦.
قبل الصلاة، لأنّ هذا المقدار الموجود في أثناء الغسل وبعده كافٍ في السببية، والعفو عنه انّما ثبت ما دام مستمرّاً، إلاّ أن نمنع سببية هذا الدم الموجود بعد الغسل وفي أثنائه، أو يقال: انّ الدم مطلقاً، أو في الوقت، وإن كان سبباً، إلاّ أنّه يعتبر في تأثيره بقاء القوّة في حال الصلاة، فإذا انتفى قوّة الجريان في حال الصلاة لم يجب الغسل.
وفيه: مضافاً إلى إمكان دعوى تسالم الأصحاب على أنّ ما كان من الدم مطلقاً، أو في الوقت، سبباً لا يكون بقاؤه قوة في وقت الصلاة معتبراً في تأثير السبب، ولذا أوجب في الذكرى(١) على من تركت وظيفة الصبح ثمّ انقطع الدم قبل الزوال أن تغتسل للظهرين، أنّ مقتضى مفهوم قولهعليهالسلام : إن كان الدم لم يسل بينها وبين المغرب، أنّ السيلان في الجملة قبل المغرب أو في أثنائه كافٍ في وجوب الغسل، ولو انقلبت قبل الصلاة الكثرة إلى القلّة.
ودعوى اعتبار صدق اسم الاستحاضة ولو كانت قليلة، بعيدة.
والحاصل: أنّ اعتبار بقاء الدم قوّة في الوقت في الدم السابق عليه عند القائل بالسببية المطلقة، وبقاؤه قوّة في وقت الصلاة عند القائل لسببية الدم في الوقت لا شاهد عليه.
ويمكن دعوى الإجماع على خلافه، وأمّا منع سببية الدم الموجود بعد الغسل وفي أثنائه فيدفعه تسالم الأصحاب على سببية الدم الموجود في الوقت.
والظاهر أنّ الإشكال في غسل الإنقطاع من جهة الإشكال في ثبوت العفو مطلقاً، أو ما دام الدم مستمرّاً. ومن هنا تعلم أنّ أكثر الفروض السابقة خارج عن محلّ البحث في غسل الإنقطاع.
وكيف كان فالأقوى بناءً على السببية وجوب الغسل لعدم الدليل على العفو،
____________________
(١) ذكرى الشيعة: مبحث الاستحاضة وأحكام الحائض، ص ٣١، س ٢٩.
ولذا قال في الذكرى(١) ووافقه في جامع المقاصد(٢) أنّما ذكره الشيخ(٣) من إيجاب الوضوء خاصة مذهب العامّة، بناءً منهم على أنّها لا توجب إلاّ الوضوء.
ثمّ إنّه يشكل الفرق بين الوضوء والغسل مع الوضوء في الكثيرة من توابع الغسل، ويمكن أن يوجّه هنا وفي بعض الصور السابقة كالصورة الاولى والثانية، إلاّ أن يفرّق بينهما، فانّ سببيّة الدم للغسل تابعة لبقائها قوّة الدم في الوقت، أو في حال الصلاة دون الوضوء، فانّ موجبه هو مطلق الإستحاضة، والقلّة والكثرة انّما يلاحظان بالنسبة إلى الغسل.
والحاصل: أنّ الإستحاضة عند الأصحاب بالنسبة إلى الوضوء كالجنابة بالنسبة إلى الغسل، وأمّا الاستحاضة الكثيرة بالنسبة الى الغسل فليست بهذه المثابة، ولا تلازم بين الغسل والوضوء بالنسبة الى العفو، ولا بالنسبة إلى السببية، وممّا يشهد بكون القليلة حكمها حكم سائر الأحداث: قولهعليهالسلام في رواية علي بن جعفر بعد السؤال عن كيفية الصلاة ما دامت ترى الصفرة: فلتتوضأ من الصفرة ولتصلّي، ولا غسل عليها من صفرة تراها، إلاّ في أيّام طمثها(٤) فانّ الغسل من الصفرة هو الغسل بعد الصفرة، فيدلّ على أنّ الوضوء منه أعمّ من الوضوء حال رؤيتها في حال عدمها.
ومما يدلّ على أنّ الغسل للإنقطاع غير واجب: موثّقة سماعة عن الصادقعليهالسلام قالعليهالسلام : غسل الجنابة واجب، وغسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل الإستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ صلاة، وللفجر غسل، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم
____________________
(١) ذكرى الشيعة: مبحث الاستحاضة وأحكام الحائض، ص ٣١، س ٢٢ وما بعده.
(٢) جامع المقاصد: الاستحاضة وغسلها ج ١ ص ٣٤٥.
(٣) المبسوط: كتاب الطهارة، في أحوال المستحاضة، ج ١، ص ٦٨، س ٧.
(٤) وسائل الشيعة: ب أنّ الصفرة والكدرة في أيّام الحيض، من أبواب الحيض، ح ٨، ج ٢، ص ٥٤١.
مرّة، والوضوء لكلّ صلاة، وغسل النفساء واجب(١) الحديث. فانّ ظاهره حصر غسل الإستحاضة بحسب المورد في صورة وجود الدم واستمراره، إلاّ أن يقال أنّ المقصود بيان كمية عدد الغسل في حال الإستمرار، وليس في مقام بيان تمام أفراده وموارده.
والحاصل: أنّه يمكن بملاحظة رواية الصفرة، وهذه الرواية، الفرق بين الوضوء والغسل، ولكنّه كما عرفت لا يخلو عن إشكال.
وأمّا الكلام في العبادة الواقعة في حال الدم فنقول: إنّ الدم إمّا أن ينقطع في أثناء الصلاة أو بعدها، وعلى أيّ تقدير، إمّا أنّها تعلم بالإنقطاع، أو تشكّ فيه، أو تعتقد خلافه، والإنقطاع إمّا لفترة تسع الطهارة والصلاة، أو للبرء.
فنقول: أمّا مع العلم بالإنقطاع فلا إشكال في فساد الصلاة، وأمّا الشك والقطع بالاستمرار فالظاهر الصحّة، لإطلاق الأخبار الشامل لصورة القطع بالإستمرار والإنقطاع بعده وصورة الشك فيه.
إلاّ أن يقال: إنّ الإذن إتكال على ظهور الاستمرار، أو يقال: إنّ مورد الأخبار هو استمرار الدم، والكلّ غير بعيد، فالمسألة لا تخلو من إشكال.
ولو علمت بالفترة وشكّت في سعة زمان النقاء للطهارة والصلاة، ففي وجوب الصبر إمّا احتياطاً، لعدم العلم ببدلية الصلاة مع الغسل، أو لأصالة عدم عود الدم إلى زمان يسع الطهارة إشكال، لإطلاق الأخبار، وما مرّ من منع الإطلاق، واقتضاء الأصل الاحتياط.
فإن قلت: أصالة عدم العود لا يثبت وجوب الصبر.
قلنا: يثبت عدم الأمر بالصلاة مع الدم، لأنّها من أحكام الاستمرار، وعلى القول بعدم الصبر لو انكشف السعة، فهل يجب الإعادة لكشف ذلك عن فساد الصلاة أم لا لظهور الإطلاق في أنّ التكليف الإضطراري الواقعي في حقّ
____________________
(١) وسائل الشيعة: كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، ح ٣، ج ١، ص ٤٦٢.
المستحاضة هو الصلاة مع الدم؟ إشكال. واشكل منه: الفرق بين صورة إعتقاد عدم الفترة، وصورة الشك في الحكم بعدم إيجاب الإعادة في الأوّل والإعادة في الثاني، إلاّ أن نمنع الإطلاق في صورة الشك، ويتمسّك في عدم إيجاب الصبر إلى أدلّة الحرج، فانّها لا توجب الإجزاء على تقدير الكشف، إذ هي لا تقتضي إلاّ رفع حرج الوجوب، وهو أعمّ من كون الإذن في حال الصلاة ظاهرياً أو واقعياً، فهو لا يوجب تعبّد التكليف بالصلاة مع الطهارة للتمكّن منها، كما هو الفرض في صورة الكشف عن سعة الزمان للطهارة والصلاة بمن لم يسبق بفعل الصلاة مع الطهارة الإضطرارية فتأمّل.
وبعبارة اخرى: الإذن في التعجيل أعمّ من كون الغسل مبيحاً واقعياً أو ظاهرياً، فما لم يبيّن الأوّل، يحكم بمقتضى إطلاق أدلّة مطلوبيّة الصلاة مع الطهارة الواقعية بوجوب الإعادة والقضاء، فافهم ذلك، واغتنم.
مسألة
ظاهر الأخبار وعبائر جملة من الأصحاب كما قيل: انّ الجمع بغسل واحد، ترخيص في الاكتفاء بغسل واحد عن الغسل لكلّ صلاة، وهذا يقتضي جواز غسل الثاني، بل عن المحقّق الثاني(١) وصاحب المدارك(٢) : القطع به.
قلت: لا إشكال انّ الجمع بغسل واحد ليس واجبا شرطياً يتوقّف صحّة الصلاة عليه، ولا واجباً نفسياً تعبدياً، إلاّ أنّ مجرد ذلك لا يكفي في صحّة الغسل مع بقاء أثر الغسل الأوّل والحكم على مشروعيته، وذلك لأنّ الأخبار الآمرة بالغسل للظهرين المشتملة على أمر مستقل بالجمع بينهما إما مطلقاً، أو بكيفية خاصة ظاهرها وجوب غسل واحد للظهرين في توقّف الإكتفاء به على الجمع، فيدلّ على أنّه مع
____________________
(١) جامعالمقاصد: الاستحاضة وغسلها، المجلد الاول ص ٤٦، س ٣٢.
(٢) مدارك الأحكام: ص ٧٣، س ١٧.
التفريق يجب غسلان، ولا دلالة فيها على استحباب غسل مستقل للعصر.
وأمّا الأخبار الآمرة بالجمع لغسل واحد، فإن كان المراد كما لا يبعد إيجاب الصلاتين معاً مع الإكتفاء بغسل واحد، فيرجع مفادها إلى الصنف الأوّل، وإن كان المراد الجمع بين الصلاتين في الغسل، فمدلولها توقّف الظهرين مجموعاً على غسل مستقل، في قبال المتوسّطة التي كانت تكتفي بغسل واحد لجميع الخمس، فيبقى الحكم بالمشروعيّة متوقّفاً على أمر هو مفقود.
نعم إن قلنا بجواز الفصل بين الصلاة والغسل بأجنبي ينافي المعاقبة كان في الأخبار الآمرة بالغسل لكلّ صلاة، أو عند وقت كلّ صلاة دلالة على ذلك، لوجوب حمل الأمر حينئذٍ على الإستحباب، مع إشكال في دلالة الأخير، لجواز أن يكون المراد من الوقت، الوقت المتعارف سابقاً، فيكون الأمر مبنيّاً على صورة التفريق.
وأمّا قولهعليهالسلام في مرسلة يونس: ثمّ تغتسل وتتوضأ لكل صلاة(١) ، فدلالته لا يخلو عن إشكال، لاحتمال أن يكون القيد راجعاً إلى الوضوء خاصّة.
وأمّا ما دل: على أنّ الطهر على الطهر حسن(٢) ، فهو مع عدم دلالته على محلّ الكلام، إذ المقصود الغسل للعصر لا بنيّة التجديد.
فمدفوع بأنّ التجديد في الغسل غير معهود، خصوصاً مع منع صدق الطهر على الغسل الغير الرافع، فالأحوط إن لم يكن أقوى ترك الغسل إن كان منافياً لمعاقبة العصر لغسل الظهر، لأنّه حينئذٍ لا يؤثّر رفعاً ولا إباحةً، فيكون أجنبيّاً محضاً.
مسألة
المشهور وجوب معاقبة الصلاة للغسل، واستدلّ له بأمور:
____________________
(١) وسائل الشيعة: كتاب الطهارة، أبواب الحيض، ح ١، ج ٢، ص ٥٤٢.
(٢) وسائل الشيعة: ب استحباب تجديد الوضوء، من ابواب الوضوء، ح ٣ و ١٠، ج ١، ص ٢٦٤ ، و ٢٦٥ وفيه أن « الوضوء بعد الطهور عشر حسنات » ولم اعثر على غيره.
منها: ظاهر قولهعليهالسلام في رواية ابن سنان: المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلّي الظهر والعصر، ثمّ تغتسل عند المغرب فتصلّي المغرب والعشاء، ثمّ تغتسل الصبح فتصلّي الفجر(١) الخبر، بناءً على ظهور « عند » في المقارنة كما هو المحكي عن السرائر(٢) ناسباً له إلى لغة العرب.
ومنها: الأخبار الآمرة بالجمع بين الصلاتين بتأخير الاولى وتعجيل الثانية(٣) ، بناءً على أنّ الظاهر هو أنّ أصل الجمع واجب، والكيفية الخاصة مستحبّ.
ومنها: أصالة عدم جواز الصلاة مع الحدث إلاّ ما خرج بالدليل، وهو صورة المقارنة.
وفي الكلّ نظر.
أمّا الأوّل فلأنّ المراد من صلاة الظهر هو زمان حضور وجوبه، ويشهد لذلك: قولهعليهالسلام عند المغرب وعند الصبح(٤) ... المعتبر في العبادات تعلّق القربة بالفعل، ولو بعنوان المغاير لعنوان الأمر، حتى تكون معنى عبادية غسل الحيض أن يكون وجوده الخارجي مقروناً بقصد القربة، وإن لم يكن المقصود القربة به، بل كان بعنوان آخر متّحد معه في الوجود، كان مقتضى ذلك سقوط الأمر المتعلّق بغسل الحيض، ولكنّ الإلتزام بذلك دونه خرط القتاد.
مع أنّ اختلاف حقائق الأغسال مع فرض اتّحادها بحسب الأجزاء والشرائط من غير إرجاعه إلى القصد مشكل، ومعه كيف يعقل حصول المأمور به من غير القصد إليه تفصيلاً أو إجمالاً ؟ فضلاً عن حصول شرائط سقوط الأمر به.
إذا عرفت ما ذكرنا، فإن كان مراد المحقّق: أنّ الغسل ماهية واحدة تعلّق بها
____________________
(١) وسائل الشيعة: الاستحاضة، ح ٤، ج ٢، ص ٦٠٥.
(٢) السرائر: في الاستحاضة من كتاب الطهارة، ص ٣٠، س ٤.
(٣) وسائل الشيعة: الاستحاضة، ح ١، ج ٢، ص ٦٠٤.
(٤) بياض بمقدار نصف صفحة في نسخة الكرباسي.
الأمر من جهات مختلفة، فقد عرفت أنّ مع ذلك ترجع الأوامر عند اجتماع الأسباب إلى أمر واحد مؤكّد، ومع هذا لا يبقى مجال لما ذكره من المناقشة من أنّ الأعمال بالنيّات(١) ، إذ المكلّف به ليس إلاّ الغسل بقصد القربة، والفرض حصوله، ولا مجال أيضاً لما ذكره من السؤال عن حصول الثواب والأجر، ولا لما استدركه بقوله: نعم لا تأبى أن تكون الإتيان الى آخره، وإن كان مراده أنّ الماهيّات المختلفة لإمكان اجتماعها يحصل عند اجتماع أسباب وجوبها بغسل واحد، فقد عرفت ما فيه من أنّ تحقّق الماهيات بدون(٢) لا يخلو عن الإشكال فضلاً عن سقوط الأوامر التعبّديّة المتعلّق بها، ويرد أيضاً على ما فرعه على قاعدة التحسين من أنّ استحقاق الفاعل للمدح مع عدم قصده عنوان الحسن، أنّه لا يتفرّع ذلك على القاعدة المذكورة.
نعم إن أراد ترتّب فوائد الفعل وآثاره المترتّبة عليه، ولو كان حصوله قهرياً كان حسناً، ولكن لا دخل لذلك باستحقاق الفاعل للمدح والثواب، كما هو ظاهر كلامهقدسسره .
قولهقدسسره في آخر كلامه: « مع أنّ ظاهر الروايات(٣) الكفاية ».
مراده: أنّ ظاهر الروايات امتثال أوامر الأغسال بغسل واحد، فلابدّ من تقييدها بمقتضى ظاهرها بعد البناء على عدم حصول الامتثال بغسل واحد بصورة نيّة الجمع.
____________________
(١) عوالي اللئالي: ح ١٩، ج ٢، ص ١١ و ح ٧٩، من نفس المصدر، ص ١٩٠.
(٢) الظاهر سقط في العبارة في نسخة الكرباسي.
(٣) وسائل الشيعة: ب أن كل غسل يجزي عن الوضوء من ابواب الجنابة، ج ١، ص ٥١٣، انظر الباب.
قولهقدسسره : « وكذا لو شككنا. الخ ».
يحتمل أن يكون مراده: أنّ الشك في كفاية غسل واحد في مقام الامتثال، يوجب الشك في كون رواية الكفاية معارضة بما هو أقوى منها، وإذا كانت الرواية حالها من حيث المعارض مجهولة لا يمكن التعلّق بها، ولكن ذلك مع إشكال في تماميّته لا ينطبق على ظاهر عبارة المحقّق.
ويحتمل أن يكون مراده: أنّ مقتضى ظاهر أوامر الأغسال، الإتيان بعنوانها الذي تعلّق الأمر به، فإن حصل القطع بحصول الامتثال عرفاً بمجرّد حصول المأمور به في الخارج من غير قصد إليه، كان ذلك مخصّصاً قطعياً لتلك الأدلّة، وأمّا مع الشك في ذلك، تكون الرواية الدالّة على غسل واحد معارضة لظاهر تلك الأدلّة، وقد عرفت أنّها أقوى من هذه الرواية، فيرجع الأمر إلى عدم العمل بعموم تلك الأدلّة مع الشك في حصول ما يوجب تخصيصها، فلا مناص في إمتثال تلك الأوامر من الإتيان بأغسال متعدّدة أو غسل واحد بنيّة الجميع، وهذا الوجه أوفق بظاهر عبارتهرحمهالله .
ثمّ إن قلنا بكفاية غسل الجنابة عن غيره، فالظاهر سقوط الوضوء، ويدلّ عليه مضافاً إلى ظهور الاتّفاق من القائلين بإجزاء غسل الجنابة عن الوضوء، على أنّه مجز عن الوضوء من كلّ سبب حتى الواجب لأجل رفع حدث الحيض، بناءً على القول بالتشريك في رافعيّة الغسل والوضوء لحدث الحيض، قوله تعالى: (وإن كنتم جنباً فاطهّروا)(١) لظهوره في عدم وجوب الوضوء على الجنب لأجل الدخول في الصلاة، بناءً على أنّه عطف على قوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم)(٢) لا على قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة)(٣) ، فمحصّل المعنى هو التفصيل بين الجنب وغيره في وجوب الوضوء
____________________
(١) و (٢) و (٣) المائدة: ٦.
للصلاة، ولو كان الجنب مسبوقاً بحدث موجب للوضوء كما هو مقتضى الاطلاق.
وقد يؤكّد الإستدلال به بما رواه محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفرعليهالسلام : إنّ أهل الكوفة يروون أنّ عليّاًعليهالسلام كان يأمر بالوضوء قبل غسل الجنابة، قالعليهالسلام : كذبوا ما وجدوا ذلك، في كتاب عليعليهالسلام : انّ اللّه عزّ وجلّ يقول: (وإن كنتم جنبا فاطهّروا)(١) فانّ الإمامعليهالسلام استشهد بالآية على عدم وجوب الوضوء، وفيه تأمّل، لإمكان أن يكون الاستشهاد لظهور الآية في كفاية الغسل لرفع الجنابة، بعد كون المقام مقام بيان تمام ما هو رافع لها، ألا ترى أنّه إذا قال الطبيب لمن [ عنده ] صداع: اشرب السكنجبين، يفهم العرف منه أنّ شرب السكنجبين كافٍ في رفع الصداع.
وممّا يؤكّد ما ذكرنا ظهور الحال في وجوب الوضوء لرفع الجنابة بقرينة قوله: قبل الغسل فانّ احتمال وجوب تقديم وضوء الصلاة على الغسل بعيد في الغاية.
والحاصل : أنّ الآية مع قطع النظر عن ظهورها في التفصيل بين الجنب وغيره، خصوصاً بملاحظة آية التيمّم(٢) ، وإن دلّت على أنّ الجنابة ترتفع بالغسل، ولا دخل للوضوء في رفعها، لا تدلّ على وجوب الوضوء للصلاة إذا كان مع الجنابة بعض أسبابه، وليس في الاستشهاد أيضاً دلالة على ذلك، فتأمّل.
ويمكن الاستدلال أيضاً بما ورد من أنّ غسل الجنابة ليس قبله ولا بعده وضوء(٣) ، بناءً على أنّ المراد وضوء الصلاة لا لرفع الجنابة، كما لا يبعد ظهوره في ذلك، حتى لا ينافي وجوب الوضوء للصلاة.
ويمكن الاستدلال بمرسلة جميل السابقة(٤) ، بناءً على ظهوره في رفع الأحداث
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة، من ابواب الجنابة، ح ٥ ، ج ١، ص ٥١٦.
(٢) المائدة: ٦.
(٣) وسائل الشيعة: ب عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة، من أبواب الجنابة، ح ٢، ج ١، ص ٥١٥.
(٤) وسائل الشيعة: ب أجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعددة، من أبواب الجنابة، ح ٢، ج ١، ص ٥٢٦.
الموجبة لسائر الأغسال، وفيه تأمّل.
ثمّ إنّ ظاهر الأصحاب كما قيل عدم الفرق في كفاية غسل الجنابة عن غيره، بين عدم الإلتفات إلى ذلك الغسل، وبين الإلتفات إليه وقصد سقوطه، وبين الإلتفات إليه وقصد عدم سقوطه.
وربما يناقش في شمول الإجماع للصورة الأخيرة. وفيه: أنّ الإجماع المنقول عن السرائر(١) وجامع المقاصد(٢) مطلق كالنص، إلا أن يدّعى انصرافها إلى غير هذه الصورة، وفيه: أنّ المفهوم من النص(٣) والإجماع أنّ كفاية غسل الجنابة عن غيره، لكونه رافعاً للأحداث الموجبة لتلك الأغسال، وأنّ ذلك من خواصه وآثاره المترتبة على حصوله، ولا دخل لقصد الفاعل فيه، كما أنّ رفع الحدث الأصغر من خواص الوضوء.
نعم من استشكل في كون الوضوء رافعاً مع قصد عدم الرفع كان إشكاله سارياً في هذا المقام أيضاً.
الصورة الرابعة: أن ينوي ما عدا غسل الجنابة، والكلام هنا في مقامين:
الأوّل: في صحّة هذا الغسل على ما نواه، وذلك بناءً على إجزائه عن غيره لا إشكال فيه، انّما الإشكال فيه على القول بعدم الإغناء عن غيره، كما هو الأقوى، نظراً إلى إطلاق الأمر المقتضي للإجزاء، وقولهصلىاللهعليهوآله : لكلّ امرئ ما نوى(٤) ، ومن أنّ صحّته في نفسه مع عدم إغنائه عن الجنابة، يوجب بقاء الأقوى مع ارتفاع الأضعف، وهو غير معقول، وأمّا الإطلاقات فلا يشمل ما نحن فيه، لأنّ وجوب غسل الحيض هنا بعد فرض إغناء غسل الجنابة عنه، لا يمكن أن يكون شيئاً
____________________
(١) كتاب السرائر: ب أحكام الجنابة، ص ٢٣، س ١٠.
(٢) جامع المقاصد: في الاغسال الواجبة من كتاب الطهارة، ج ١، ص ٥، س ١٦.
(٣) وسائل الشيعة: ب اجزاء الغسل الواحد عن الاسباب المتعددة، ح ٢، ج ١، ص ٥٢٦.
(٤) وسائل الشيعة: ب وجوب النية في العبادات، من كتاب الطهارة، ح ٧ و ١٠، ج ١، ص ٣٤.
من أقسام الوجوب، فلا يكون واجباً.
بيان ذلك: أنّ الوجوب العيني خلاف مقتضى الإجماع على إغناء غسل الجنابة، لأنّ تعيّن الشيء مع تعيّن المسقط لغو، والتخييري غير معقول، وأمّا الثاني أعني الوجوب التخييري فلا مانع منه، إذ رفع الحدث لما يشترط فيه الطهارة واجب عند وجوبه، فيجب سببه الذي هو أحد الأمرين من غسل الجنابة والحيض، غاية الأمر أنّ غسل الجنابة يجب من جهتين لتأثيره في رفع حدث الجنابة والحيض.
المقام الثاني : في كفاية هذا الغسل عن غسل الجنابة، فعن المحقّق في الشرائع(١) والمعتبر(٢) والشهيدين(٣) و(٤) والمحقق الثاني(٥) هو ذلك، بل عن بعض(٦) نسبته إلى المشهور، [ وعن الشيخ(٧) ، والسرائر(٨) ، والوسيلة(٩) ، وبعض كتب العلاّمة(١٠) ، والإيضاح(١١) ، والموجز(١٢) ، وشرحه(١٣) ]، بل عن أكثر من تعرّض للمسألة عدم الكفاية، بل قد يستظهر من عبارة السرائر(١٤) المحكيّة شمول الإجماع المدّعى فيها
____________________
(١) الشرائع: فصل في كيفية الوضوء ج ١، ص ٢٠.
(٢) المعتبر: كتاب الطهارة: في الأغسال المندوبة، ص ٩٩، س ١٧.
(٣) الذكرى: ما يجب الغسل، ص ٢٥، س ٦.
(٤) المسالك: في الوضوء ج ١، ص ٥، س ٣١.
(٥) جامع المقاصد: ب أسباب الطهارة، ج ١، ص ٥، ص ١٦.
(٦) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة، ص ٢٩، س ١٨.
(٧) المبسوط: كتاب الطهارة، فصل في ذكر الاغسال، ج ١، ص ٤٠.
(٨) السرائر: ب أحكام الجنابة، ص ٢٣، س ١٨.
(٩) الوسيلة: ب أحكام الحيض، ص ٥٦، س ٧.
(١٠) قواعد الأحكام: كتاب الطهارة، ص ٣، س ١٥.
(١١) أيضاح الفوائد: كتاب الطهارة، ج ١، ص ١٢، س ٤.
(١٢) الموجز: المصدر غير موجود.
(١٣) شرح الموجز: المصدر غير موجود.
(١٤) السرائر: احكام الجنابة: ص ٢٣، س ١٠.
على كفاية غسل الجنابة عن غسل الحيض، لعدم كفاية غسل الحيض عن الجنابة، قال: إن كانت المرأة حائضاً ثمّ طهرت فقبل أن تغتسل جاءها زوجها، فالواجب عليها أن تغتسل غسل الجنابة دون الحيض، لأنّ غسل الجنابة له مزيّة وقوّة وترجيح على غسل الحيض، لأنّه لا خلاف في أنّه يستباح بمجرّده الصلاة وليس كذلك غسل الحيض، وأيضاً غسل الجنابة قد عرفت وجوبه من القرآن، وغسل الحيض عرفت وجوبه من السنّة المتواترة، ثمّ قال: والمعتمد في ذلك الإجماع، انتهى. فانّ الإجماع المدّعى، إن كان على أنّ الواجب نية الجنابة دون الحيض، فظاهر أنّه يقتضي عدم كفاية غسل الحيض عن الجنابة، لأنّ الوجوب المنفي عن نيّة غسل الحيض الثابت لغسل الجنابة، إمّا مطلق الوجوب أو الوجوب العيني، ولا ريب أنّ ثبوت الوجوب العيني لغسل الجنابة، وعدم ثبوته لغسل الحيض، أو عدم ثبوت الوجوب مطلقاً له لازم، لعدم كفاية غسل الحيض عن غسل الجنابة، وإن كان على ثبوت المزية المقتضية لكفاية غسل الجنابة عن غسل الحيض دون العكس فتثبت المزية المذكورة، فيثبت المطلوب.
ولكن لا يخفى أنّ الإجماع على هذا التقدير على المزيّة، وأمّا اقتضاؤها عدم كفاية غسل الحيض عن غسل الجنابة فهو اجتهاد لا ربط له بمعقد الإجماع.
وكيف كان فاستدلّ للأوّل بإطلاق ما دلّ(١) على كفاية غسل واحد، وبأنّ غسل الحيض غسل صحيح نوى به الاستباحة، فيجب أن يكون رافعاً لحدث الجنابة، وبأنّ الحدث الذي هو نجاسة معنوية أمر واحد، وإن تعدّد أسبابه.
والجواب أمّا عن الاطلاق فبالمنع، وعن الثاني والثالث بمنع الملازمة والاتّحاد، مضافاً إلى الموثّق(٢) الدالّ على وجوب غسل الجنابة، وعدم سقوطه بغيره.
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب أجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعددة، من أبواب الجنابة، ح ٢، ج ١، ص ٥٢٦.
(٢) وسائل الشيعة: ب وجوب غسل الجنابة، من أبواب الجنابة، ج ١، ص ٤٦٢ - ٤٦٥. انظر الباب
وقد يستدلّ أيضاً بما مرّ من الاخبار(١) الدالّة على أنّ غسل الجنابة والحيض واحد، وقد عرفت الجواب عنها.
وقد يستدلّ أيضاً بما دلّ(٢) على أنّ الحيض أعظم من الجنابة، فترتفع الجنابة برافعه، كما أنّ الحدث الأصغر يرتفع برافع الأكبر.
وفيه: أنّ الأعظميّة لم يعلم أنّها من حيث النجاسة، بل لعلّها لعدم قابلية الإرتفاع المانع عن الوجوب، بل وجوب الصلاة، فلا مجال لوجوب غسل الجنابة، ولو سلّم، فلا دليل على أنّ رافع كلّ اكبر رافع للأصغر، ألا ترى أنّ الحدث الأكبر المانع عن قراءة العزائم ودخول المساجد ترتفع بغسل الحيض، ولا يرتفع الأصغر إلاّ مع الوضوء، وبالجملة لا دليل يوجب الخروج عن مقتضى الأصل.
ومما ذكرنا يعلم عدم كفاية غسل الحيض عن غسل الإستحاضة، وغسل المس، وغيرهما من الأغسال الواجبة، وقد يستظهر من المحقّق(٣) والعلاّمة(٤) في بعض كتبه: أنّ الخلاف في إغناء غسل الحيض من غسل الجنابة، مبني على القول بعدم إغنائه عن الوضوء كما هو المشهور، ولعلّ وجهه اتّحاد حقيقة الأغسال، وعليه فلا ينبغي الخلاف في إغناء غسل الحيض، عن غير غسل الجنابة من الأغسال، ولكن الاتّحاد محلّ المنع، والاتّفاق لم يثبت.الصورة الخامسة: أن ينوي غسلاً مطلقاً ينوي به استباحة الصلاة، أو القربة، والكلام فيه هو الكلام في إغناء غسل الحيض عن غيره، بل لا يجري فيه بعض ما مرّ.
والحاصل: أنّك قد عرفت سابقاً: أنّ مقتضى ظاهر جملة من الأخبار، اختلاف
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب أجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعددة، من أبواب الجنابة، ج ١ ص ٥٢٦ - ٥٢٨، انظر الباب.
(٢) وسائل الشيعة: ب أن الحائض لا يرتفع لها حدث، من ابواب الحيض، ح ٢، ج ٢، ص ٥٦٦.
(٣) المعتبر: في اجزاء الغسل عن الوضوء، ص ٥١، س ٢٩.
(٤) منتهى المطلب: كتاب الطهارة: ج ١، ص ٩١، س ٨.
ماهية الأغسال، فعند تحقّق أسبابها واشتغال الذمة بها، يجب تحصيل الفراغ، والعلم به لا يحصل من الإتيان بغسل مجرّد، إذ لعلّها متباينة أو متصادفة يتوقّف تصادفها على نية الجمع، على أنّا لو سلّمنا عدم ثبوت اختلاف الماهية، فالشك فيه كافٍ في عدم الاكتفاء بغسل مجرد، لأنّ تعدّد الأوامر معلوم، والشكّ في حصول الفراغ عن عهدة تلك الأوامر، إذ لم يثبت أنّ متعلّق تلك الأوامر ماهية واحدة، بل لعلّها متباينة، أو متصادقة يتوقّف تصادقها على نيّة الجميع.
فإن قلت: إنّ القدر المعلوم ثبوته في كلّ من هذه الأوامر هو إرادة الغسل المردّد بين كونه هو مطلق طبيعته، أو نوعاً منه، ومع الشك في الأقلّ والأكثر، الأصل البراءة، فالقدر الذي يحكم العقل بإشتغال الذمة به في هذه الأوامر، هو تحصيل صرف الطبيعة التي تحصل قطعاً بالإتيان بغسل مجرّد، والقيود الزائدة التي لا يعلم اجتماعها في فرد واحد، لا يعلم التكليف بها، والأصل البراءة عنها.
قلت: لمّا علم من الخارج أنّ مطلوبية الغسل هنا غيرية لأجل رفع ما حدث بتلك الأسباب لم يجز الإكتفاء مع الشكّ في ارتفاع الحادث بغسل مجرد، ومسألة البراءة، والاحتياط، مع قطع النظر عن هذه الجهة، وأمّا في مثل هذه الصورة فلا ريب أنّ الأصل هو الاشتغال.
فإن قلت: إذا فرضنا أنّ ظاهر الدليل اقتضاء كلّ واحد من الأسباب شيئاً ولم يعلم أنّ مقتضاها هو الطبيعة، أو أنواع بما يحسب ظاهر اللفظ كان ظهور الدليل في فعلية اقتضاء كلّ واحد من الأسباب كافياً في إثبات اختلاف حقائق الأغسال، إذ مع فرض اتّحاد الماهية لا يكون المقتضي الفعلي إلاّ الحادث أولاً.
قلت: اقتضاء كلّ واحد الغسل، قد يكون لأجل إحداثه أمراً متبايناً لما حدث بالأوّل، وقد يكون لأجل تأكّد الحادث أوّلاً، والذي ينافي اتّحاد الحقيقة بناءً على أنّ اختلاف الأحداث يوجب اختلاف الأغسال هو الأوّل، وظاهر الأدلّة لا يعيّن الأوّل، وكون المقتضي فعلاً هو السبب الأوّل ممنوع، لأنّ اقتضاء كلّ سبب لذات الغسل فعلي.
نعم اقتضاء السبب للأمر بالغسل فعلي بالنسبة الى السبب الأوّل، وشأني بالنسبة إلى الثاني، لأنّه لا يعقل تأثيره بعد حصوله، ولكنّه أيضاً يؤثّر تأكّد الأمر كما لا يخفى، فتأمّل.
فإن قلت: إنّا نشك في أنّ الحادث بالسبب الثاني أمر مغاير للحادث بالسبب الأوّل، بحيث يقتضي رافعاً مخالفاً للرافع الأوّل ولو بحسب الماهية، ومع الشك في ذلك، الأصل البراءة عن التكليف الزائد عن ما يثبت بأوّل الأسباب.
قلت: إذا سلّمت أنّ ظاهر الدليل هو اقتضاء كلّ سبب حتى عند اجتماعه مع سابق عليه حصول الغسل، أو نوع منه، وعلم من الخارج أيضاً أنّ ذلك لا يكون إلاّ لأجل تأثير السبب أثراً يجب رفعه، وأنّ مطلوبية الغسل ليس إلاّ لأجل تأثيره في رفع ذلك الحادث، غاية الأمر أنّ الأثر الحادث ثانياً، إن كان واقعه غير رافع الأثر الحادث كان السبب موجباً لتأكّد مطلوبية ذلك الرافع، وإن كان مغايراً كان السبب موجباً لحدوث تكليف كان اللازم هنا الاحتياط لا غير، إذ تحصيل الفراغ برفع آثار الأسباب واجب مقدّمة للدخول فيما يتوقّف على دفعها، ولا يحصل اليقين إلاّ بالاحتياط.
نعم لو فرض الشك في حصول أثر للسبب الثاني، مغايراً لأثر السبب الأوّل أو متّحداً، كان أصالة عدم حدوث الأثر الجديد سليمة عن المعارض، ولكنّ ذلك أيضاً لا يجدي في الاكتفاء بالغسل المجرّد، إذ لعلّ رافع السبب الأوّل غسل خاص لا يحصل بالغسل بقصد القربة من غير قصد إلى أمر آخر، ولو إجمالاً.
نعم لو كان لإطلاقات الأوامر ظهور في أنّ المطلوب هو الغسل من حيث هو كان مقتضى ذلك الظهور بضميمة الإجماع السابق الإكتفاء بالغسل بقصدالقربة. فتلخّص من جميع ما ذكرنا: أنّ مقتضى الأصل عدم الإكتفاء بالغسل المجرّد بقصد القربة، أو المنويّ به استباحة الدخول في العبادة، إذا لم يرجع ذلك إلى قصد جميع الأغسال، ولقد أطلنا الكلام خوفاً عن فوت بعض ما يجب التنبيه عليه، هدانا اللّه وإيّاك إلى صراط مستقيم، أنّه حميد مجيد.
ثمّ إنّ المحكيّ عن المحقّق القميقدسسره (١) : أنّ الأكثر على أنّ التداخل في مورد جوازه رخصة لا عزيمة.
وفيه إشكال، لأنّ المكتفي بكلّ واحد من الأغسال عن غيره سواء بني على إغناء كلّ غسل عن الوضوء، أو خصّ ذلك بالجنابة لا يبقى عنده مورد حتى للغسل ثانياً، وأمّا من خصّ ذلك بغسل الجنابة وأنكر التداخل في غيره، فإن بنى على أنّ تقديم غير غسل الجنابة عليه لا يكون في نفسه صحيحاً أيضاً، كما هو المحكيّ عن بعض كلمات العلاّمة(٢) ظاهراً، فلا ريب أنّ التداخل عليه أيضاً عزيمة.
نعم إن قلنا بصحّة الغسل المقدّم كما هو الأقوى، وقد عرفت وجهه مفصّلاً، كان التداخل رخصة.
ثمّ إنّ الغسل الواحد الكافي عبادةً يحتاج إلى أمر، وذلك بناءً على أصالة التداخل في الأسباب، هو الأمر الحادث بالسبب الأوّل، وبناءً على أصالة التداخل في الإمتثال - كما اختاره المحقّق الخوانساري -رحمهالله (٣) - هو كلّ واحد من الأوامر، وللمكلّف أن يقصد جمعها وبعضها، إذ عرفت أنّ المعتبر عنده في امتثال الأمر التعبّدي هو قصد القربة ولو لأمر آخر، وأمّا بناءً على أصالة عدم التداخل في الأسباب والإمتثال، فإن كان إطلاق الأخبار في كفاية كلّ غسل حتى الغسل المجرد تامّاً، كان ذلك كاشفاً عن وحدة الحقيقة، فالأمر هو الحادث بأوّل الأسباب، وإن لم يثبت، وقد عرفت أنّ مقتضى كثير من الأخبار إختلاف ماهية الأغسال، فالأمر الموجود هو الأوامر المتعلّقة بتلك الماهيّات المختلفة، ولا يسقط شيء منها إلاّ بقصده في نفسه، غاية الأمر أنّه يمكن قصد امتثال الجمع لفعل واحد، وأما كفاية غسل الجنابة عن غيره، بناءً على ذلك فليس من باب الإمتثال، بل هو مسقط حقيقة لأوامر تلك الأغسال.
____________________
(١) لم نعثر عليه.
(٢) قواعد الأحكام: كتاب الطهارة، الفصل الثاني، ص ٣ ، ص ١٥.
(٣) مشارق الشموس في شرح الدروس: ص ٦١، س ٣١.
المسألة الثانية
أن تجتمع أغسال مندوبة.
والكلام هنا أيضاً تارة في إجزاء غسل واحد بنيّة الجميع، واخرى في إجزاء غسل واحد بنية بعضها، أما الأوّل فالظاهر كما عن المشهور، هو الإجزاء، وعن ظاهر الإرشاد(١) عدمه، وهو كما عرفت أوفق بالأصل، إلاّ أنّ ظاهر الصحيحة المتقدّمة(٢) يطابق المشهور، واحتمال اختصاص ذلك بما لو كان الأغسال المجتمعة مشتملاً على واجب ضعيف، وإلاّ كان إحتمال الإجزاء في الواجبات أيضاً بما لو كان معها غسل مستحب متطرّقاً، مع أنّ قولهعليهالسلام : إذا اجتمعت للّه عليك حقوق(٣) عام لجميع الصور.
ودعوى ظهور الحقوق في الواجبات.
مدفوعة بظهور تفرّع الكلّيّة على الكلام السابق، وهو قرينة على أنّ المراد أعمّ، وأمّا الثاني فالظاهر عدم إجزائه عن غيره، كما أنّ الظاهر صحّته، أمّا الأوّل فللأصل، وعدم الدليل الصالح لتخصيصه، عدا إطلاق الصحيحة، وقد عرفت منعه بما لا مزيد عليه.
وقد يستدل للإجزاء: بقولهعليهالسلام في رواية عثمان بن يزيد إن اغتسل بعد الفجر كفاه غسله الى الليل في كلّ موضع يجب فيه الغسل، ومن اغتسل ليلاً كفاه غسله إلى طلوع الفجر(٤) . وحكي عن جماعة(٥) الاعتناء بدلالتها، وعن بعض(٦)
____________________
(١) إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة ج ١، ص ٢٢١.
(٢) وسائل الشيعة: ب أجزاء الغسل الواحد عن الاسباب المتعددة، من أبواب الجنابة، ح ٢، ج ١، ص ٥٢٦.
(٣) وسائل الشيعة: ب أجزاء الغسل الواحد، من ابواب الجنابة، ح ١، ج ١، ص ٥٢٦.
(٤) وسائل الشيعة: ب انه يجري الغسل اول النهار ليومه بل وليلته، من ابواب الاحرام، ح ٤ ج ٩، ص ١٤.
(٥) الحدائق الناضرة: تداخل الأغسال، ج ٢ ، ص ٢٠٢ ، س ٣ وما بعده.
(٦) الحدائق الناضرة: تداخل الأغسال، ج ٢، ص ٢٠٢، س ١ و ٢.
الإهتمام بسنده، حتى قيل: انّ عثمان بن يزيد مصحّف عمر بن يزيد، بقرينة رواية عذافر عنه.
أقول: إما أن يكون المراد من الغسل مطلقه الشامل للواجب والمستحب، والمجرّد عن قصد خصوصية، أعني الغسل بقصد القربة، ويكون المراد حينئذٍ أنّ من صدر منه غسل يكفيه ذلك الغسل لكلّ مكان يحتاج الغسل لأجل الدخول فيه إلى الليل، ولو كان ذلك الغسل لكلّ مكان يحتاج الغسل لأجل الدخول فيه إلى الليل ولو كان ذلك الغسل لأمر آخر غير الدخول في ذلك المكان، فتدلّ الرواية بإطلاقها على أنّ الغسل واجباً كان أو ندباً يجزئ عن الغسل لأجل المكان، سواء كان المكلّف قاصداً للدخول في ذلك المكان وملتفتاً إلى أنّه يكون الغسل له راجحاً شرعاً، أو لم يكن قاصداً، أو كان قاصداً وغير ملتفت، فتدلّ بضميمة عدم القول بالفصل أنّ المستحب من الأغسال يسقط بمثله وبالواجب، وإن كان الغسل المسقط سابقاً على التكليف ممّا يسقط به، فيكون مدلول الرواية حكمان:
أحدهما: إجزاء كلّ غسل عن الغسل المستحبّ.
والثاني: بقاء أثر الغسل الرافع في أوّل الفجر من حيث الإجزاء عن غسل المكان إلى الليل.
وأمّا أن يكون المراد خصوص الغسل لأجل الدخول في مكان، ويكون المراد أنّ الغسل لأجل الدخول في مكان يترتّب عليه فضيلة الدخول مع الغسل في ذلك المكان إلى الليل، وكذلك إذا كان في الليل إلى الفجر، والظاهر أنّ الرواية في مقام بيان بقاء أثر الغسل الرافع في أوّل الفجر إلى الليل، والرافع في الليل إلى الفجر، وليس فيه إطلاق بالنسبة إلى الغسل المجزي، ويشهد له الفقرة الثانية، كما لا يخفى على المتأمّل.
فحاصل معنى الرواية أنّ الغسل الذي يكفي لأجل الدخول في المكان إذا وقع في أوّل الفجر يبقى أثره إلى الليل، وإن وقع في أوّل الليل يبقى أثره إلى الفجر، فليس لها إرتباط بمسألة التداخل في الأغسال أصلاً وإطالة البيان لغرض التوضيح.
وإزالة ما يقع في النفس من الشبهة في بدو النظر في الرواية، وأمّا صحّته في نفسه فلإطلاق الأمر المتعلّق به. فتبيّن أنّ التداخل رخصة لا عزيمة.
وهل يكفي بناءً على كفاية الغسل الواحد بنيّة الجميع أن يأتي بغسل واحد بقصد كلّ غسل عليه في الواقع وان لم يعلم به، أو يجب العلم بما يلزم تفصيلا ؟
الأقوى: بناءً على عدم جواز الإحتياط مع التمكّن من العلم التفصيلي هو الأوّل.
المسألة الثالثة
أن تجتمع أغسال بعضها واجب وبعضها مندوب.
والكلام هنا تارة في إجزاء الواجب عن غيره واخرى في العكس.
أمّا الأوّل فالمشهور كما عن جماعة(١) سقوط المستحبّ به إن كان غسل جنابة، وعن غير واحد حكاية الإتّفاق عليه، وهو المحكي عن ظاهر السرائر(٢) .
ويدلّ عليه: مضافاً إلى ذلك، مرسلة جميل المتقدّمة(٣) .
وفحوى ما روي في باب الصوم من كفاية غسل الجمعة لمن نسى غسل الجنابة(٤) ، مع أنّ المقصود من الغسل المندوب ليس إلاّ التنظيف الحاصل بالغسل الواجب.
وقد يناقش في المرسلة بالإرسال، وضعف الدلالة، إذ لعلّ المراد من إغتسال
____________________
(١) منتهى المطلب: كتاب الطهارة ج ١، ص ٩١، س ١.
(٢) السرائر: كتاب الطهارة: ج ١، ص ٢٣ ، س ٨.
(٣) وسائل الشيعة: ب أجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعددة، من ابواب الجنابة، ح ٢، ج ١، ص ٥٢٦.
(٤) وسائل الشيعة: ب حكم من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان، من ابواب الصوم، ح ٢، ج٧ ، ص ١٧٠.
الجنب اغتساله بنيّة جميع ما عليه من الأغسال، وفي الفحوى بمنع أصله ولو سلّم فهو في حال النسيان، ولعلّنا نقول به في الفرع على تقدير تسليم الاصل، ولعلّه لذلك - مضافاً إلى الأصل، وقولهعليهالسلام : انّما الأعمال بالنيات(١) ، وقولهصلىاللهعليهوآله : لكلّ أمرئ ما نوى -(٢) ، إستشكل المحقّق في المعتبر(٣) ومنع العلامة(٤) والمحقّق الثاني(٥) كما حكي عنهم.
وأمّا الإلتفاقات المحكية فموهونة بخلاف هؤلاء الأجلّة.
ولكنّ الإنصاف: أنّ القول بالإجزاء لا يخلو عن قوّة، لأنّ الإرسال منجبر بالعمل بالرواية، وضعف الدلالة ممنوع، واستقرار الجماعة على الخلاف غير معلوم، فينبغي التأمّل في عبائرهم.
ومن هنا ظهر: عدم إجزاء غير غسل الجنابة من المستحبّ، وأمّا الثاني فيعلم حال إجزائه عن الواجب بالتأمّل فيما ذكرنا، وهل يكون صحيحاً في نفسه، أو تتوقّف صحّته على تقديم الواجب عليه، حتى إذا لم يكن الواجب مسقطاً عنه كغسل الحيض، والمس، لعدم إمكان حصول النظافة ؟ وجهان: أقواهما: الأوّل: لإطلاق الأوامر المتعلّقة بها، وعدم وجود ما يصلح لتقييدها، عدا تخيّل عدم حصول النظافة المقصودة للمحدث، وهو ضعيف، خصوصاً مع ورود(٦) الأمر بغسل الإحرام للحائض، وهو كاشف عن حصول التنظيف له، ولو نوى الواجب والمندوب أجزأ عنهما، لرواية الحقوق(٧) السابقة، بل هو المتيقّن من مدلولها كما عرفت، وحيث
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب وجوب النية في العبادات من كتاب الطهارة، ح ١٠ ، ج ١، ص ٣٤ و ٣٥.
(٢) وسائل الشيعة: ب وجوب النية في العبادات من كتاب الطهارة، ح ١٠، ج ١، ص ٣٤ و ٣٥.
(٣) المعتبر: كتاب الطهارة، ص ٩٩، س ٢٠.
(٤) قواعد الاحكام: كتاب الطهارة، ج ١، ص ٣، س ١٥.
(٥) جامع المقاصد: كتاب الطهارة، ج ١، ص ٥، س ١٦.
(٦) وسائل الشيعة: ب وجوب الاحرام على الحائض من ابواب الاحرام، ح ٢، ٣، ٤، ٥، ج ٩، ص ٦٥.
(٧) وسائل الشيعة: ب اجزاء الغسل الواحد، من ابواب الجنابة، ح ١، ج ١، ص ٥٢٦.
دلّت تلك الرواية وغيرها من الأمارات الاخر: أنّ الأغسال حقائق فهل به تجتمع في مصداق واحد، كان الغسل الواحد المنويّ به غسلان فرداً لعنوانين مختلفين في الحكم في أنفسهما، وكان ذلك الغسل مجمعاً لهما، فهذا الفرد مجمع لجهتين: الوجوب، والاستحباب، وأمّا فعليّة الحكمين فيه فهو غير ممكن، لاجتماع حكمين مختلفين في النوع، أو متّحدين فيه في محلّ واحد غير ممكن، أمّا الأوّل فلتضادّهما بالغرض، وأمّا الثاني فلإمتناع اجتماع المثلين في محلّ واحد.
ومن هنا يشكل الأمر بناءً على اعتبار نيّة الوجه في صحّة العبادة إذا نوى الغسلين معاً.
فعن المختلف: أنّه إن نوى الوجوب عن الجمعة والجنابة لا يجزئ، لأنّه نوى الوجوب عمّا ليس بواجب، وإن نوى الندب لم يرفع غسل الجنابة على وجه، وإن نواهما معاً كان الفعل الواحد قد نوى فيه الوجوب والندب فلا يقع عليهما ولا على أحدهما، لأنّه ترجيح بلا مرجّح انتهى(١) . ينبغي أوّلاً توضيح الإشكال، ثمّ التصدّي للجواب بما يقتضيه الحال.
فنقول: إذا اجتمع عنوانان: أحدهما واجب والآخر مندوب في مصداق واحد، فلا ريب أنّ ذلك المصداق الواحد لا يكون واجباً ومندوباً، وحينئذٍ فإمّا أن نقول: إنّ ذلك الفرد ليخرج عن العنوانين، لأنّ المقتضي للدخول في كلّ واحد موجود، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، أو نقول: إنّه متّصف بالوجوب، لأنّ الجهة المانعة عن النقيض لا تزاحمه الجهة الغير المانعة، لأنّ ما لا يقضي المنع لا يزاحم ما يقتضي المنع.
نعم لو كان جهة الاستحباب مقتضية للإذن في الترك لا من حيث نفس عنوان المأمور به، بل كان كذلك حتى بالنسبة إلى الطوارئ اللاحقة للمأمور به من العناوين المتحّدة معه مصداقاً في بعض الأحيان، تعارضت الجهتان، وكون النتيجة.
____________________
(١) مختلف الشيعة: في الأول في أقسام الغسل، ج ١، ص ٢٩، س ١٨.
حينئذٍ أيضاً خروج ذلك المصداق عن الوجوب والاستحباب، فيه إشكال بل منع، ولعلّه يأتي إن شاء اللّه تعالى بيانه.
إذا عرفت ذلك فنقول: مقتضى الوجه الأوّل أنّ الغسل بقصد الجمعة والجنابة سواء قصد الوجوب، أو الندب، أو أحدهما خاصة، لا يكون مجزياً عن شيء منهما، أمّا اذا نوى الوجهين فظاهر، لأنّ وقوعه على أحدهما ترجيح بلا مرجّح، وعليهما غير ممكن، وأمّا إذا نوى أحدهما، فعدم وقوع ما لم ينو وجهه ظاهر، لأنّه لم يأت بتمام ما يعتبر في سقوط الأمر، وأمّا ما نواه فلأنّه خارج عن مورد الأمر المتعلّق به، إذ الفرض أنّه تعارض الجهتان فخرج المورد عن الحكمين. ويمكن أن يكون مرجع كلام العلاّمة في المختلف إلى ذلك.
ومقتضى الوجه الثاني أنّه إذا نوى الوجوب خاصّة، يقع ما كان الوجوب جهته، وأمّا ما كان جهته الاستحباب فلا يقع، لأنّ قصد الوجوب في الفرد لا يجامع قصد إمتثال الأمر الندبي.
والحاصل: أنّ الإتيان بمصداق العنوانين لكونه واجباً لا يجامع قصد موافقة الأمر الندبي به، وإذا نوى الوجوب والندب فلا يقع إمتثال الأمر الندبي به، لأنّه لا يتّصف بالندب فلا يقع امتثالاً له، وأمّا الأمر(١) .
____________________
(١) هنا سقط في العبارة في نسخة الكلباسي إلى آخر البحث.
رسالة في أحكام الخلل في الصلاة
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه رب العالمين و الصلاة على سيد الأنبياء وآله السادات الأوصياء واللعنة على اعدائهم الأشقياء.
الفصل الخامس
في السهو
خروج الصلاة عرفاً عن قابليّة الامتثال: إمّا بحصول نقصٍ فيها عن عمدٍ أو جهلٍ، أو نسيان للحكم أو الموضوع
وأمّا بالشكّ المردّد للأمر بين حصول الزيادة، أو النقيصة المبطلين فينتفي طريق حصول اليقين بالامتثال بها إلاّ الإعادة، أو طريق ظاهريً يبحث عنه في باب الخلل.
فمن ترك شيئاً من واجبات الصلاة عمداً بطلت صلاته، وإن كان جاهلاً عدا الجهر والإخفات فقد عذر لو جهلهما.
لا إشكال في أنّ العمد الذي هو الاختيار لا يصدق على التارك لجهل بالموضوع، فمن ترك الستر أو غيره من الشرائط جهلاً لا يصدق عليه أنّه تارك عمداً. نعم، من ترك - جاهلاً بالحكم - عامد.
وكيف كان، فلا ريب في أنّ اجزاء الناقص يحتاج الى دليل، وقد وصل في مواقع:
منها: ما ذكره المصنّف. والأصل فيه - قبل الإجماع - صحيحة زرارة: (في رجلٍ جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر به، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقالعليهالسلام : « أي ذلك فعل متعمّداً فقد نقص صلاته، وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسياً، أو لا يدري فلا شيء عليه »)(١) . والظاهر(٢) من القراءة، مضافاً الى أنّه القرآن هو حكايته فلا يشمل التسبيح من وجهين. والظاهر من الوصول هو المحلّ الذي لا يجهر فيه، وحمله على الصلاة أو خصوص الركعة يحتاج الى دعوى انصرافٍ، هي في محلّ المنع.
والظاهر من قوله: « لا ينبغي » كونه كذلك بالأصل، لا بالعارض، فيشكل الحكم في تسبيح الأخيرتين، وفي قراءة المأموم المسبوق اذا جهر بها، بل لا يخلو الجهر بالقراءة في الأخيرتين عن الإشكال.
ويمكن دفع الإشكال فيها، وفي التسبيح بأنّ الأخيرتين تابعتان للأوّلتين اللتين هما فرض اللّه، بخلاف الأخيرتين فأنّهما فرض النبيّصلىاللهعليهوآله ، فهما بالعذر أولى من الأوّلتين، مضافاً إلى عدم ظهور الخلاف، بل يمكن حمل القراءة في كلام الراوي على المثال.
ولو التفت الى إبدال الجهر بالاخفات، ومحلّ القراءة باقٍ فإن قلنا: إنّ الجهر كيفيّة معتبرة في القراءة كان مقتضى القاعدة إعادة القراءة، وان قلنا: إنّها معتبرة في الصلاة، ومحلّها القراءة فلا يجب فوات محلّها.
ويشهد للأخير قولهعليهالسلام : « فقد نقص صلاته » فأنّه ظاهر في أنّه حين الإبدال نقص الصلاة من حيث تفويت الجهر، لا فوات القراءة خاصّةً، ولا حصول الزيادة، ولو قرأ بالصاد المهملة كانت دلالته على ما ذكرنا أقرب من وجهٍ، مضافاً
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب وجوب الإعادة على من ترك الجهر والاخفات ح ١، ج ٤، ص ٧٦٦، مع اختلاف يسير.
(٢) في « ط ٢ »: « والمطلق ».
الى أنّ قولهعليهالسلام : « فلا شيء عليه » ظاهر في أنّه حين الإبدال لا شيء عليه، وحمله على الالتفات بعد الصلاة تكلّف بلا وجه.
ثمّ إنّ الجهل بموضوع الجهر والاخفات كالجهل بحكمه، وكذلك كلّ إبدالٍ وقع لا عن عمدٍ، لأنّ الظاهر من الرواية أنّ الوجوب للإعادة هو العمد، لا غيره.
ومنها: الجهل بغصبيّة المكان للصلاة، أو لماء الوضوء.
فقد قيل(١) : بأنّه لا يوجب البطلان، والظاهر أنّ ذلك لانتفاء النهي حينئذٍ.
لا يقال: لا يرتفع النهي بالجهل بالموضوع، بالمانعيّة المنتزعة منه باقية واقعاً.
لأنّا نقول: لم يتوجّه النهي التكليفيّ بنفس العبادة، بل المانعيّة منتزعة من زوال الأمر بمزاحمة النهي، وهي منتفية مع الجهل، لأنّ مخالفته مرخّص فيها بالفرض، إذ الكلام في الجهل، الذي هو عذر - ولا يعقل مزاحمة الأمر بنهيٍ - رخّص في مخالفته.
لا يقال: النهي - واقعاً - موجود، فالتنافي في مورد الإجتماع موجود، فإن خصّص الأمر بغير مورد الغصب كان الفرد المأتيّ غير مطابقٍ للأمر الواقعيّ.
لأنّا نقول:
أولاً: نمنع مزاحمة الأمر والنهي الواقعيّين، وأنّما هي عند فعليتهما.
وثانياً: نمنع بقاءها بعد عروض الشأنيّة، بعد فعلية الرخصة على الخلاف في أحدهما، عقلاً أو نقلاً، فالمنافاة أنّما هي في مرتبة الذات، لملحوظيّته مرتبة الفعليّة فيه، وبعد تحقّق عروض الشأنيّة في المرتبة المتأخّرة، التي هي مرتبة الجهل بالحكم ترتفع المزاحمة.
وثالثاً: مناط الأمر موجود، فالأمر بالصلاة ظاهراً - حينئذٍ - كافٍ في الاجزاء واقعاً ولو كان الأمر الظاهري مخالفاً للأمر الواقعي.
____________________
(١) البيان: في مكان المصلي ص ٦٣، س ٨.
وقد حكي عن سيّد مشايخنا - رضوان اللّه عليه - في بعض مباحثه المباركة الشريفة ترجيح الوجه الثاني من الوجوه المذكورة.
ومنها: الجهل بنجاسة ما يجب طهارته في حال الصلاة، الذي منها محل السجود، وهو فيما عدا الأخير اذا كان العلم بالنجاسة بعد الصلاة لا إشكال فيه. وقد نطقت(١) به أخبار كثيرة:
منها: صحيحة زرارة الطويلة، التي شاع التمسك بها في باب الاستصحاب، وفيها: (فإن ظننت أنّه أصابه ولم أتيقّن ذلك، فنظرت ولم أر شيئاً فصلّيت فيه فرأيت فيه، قال: تغسله، ولا تعيد الصلاة. قلت: لم ذلك؟ قال: لأنّك كنت على يقين من طهارتك، فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً (الى أن قال): قلت: فهل عليّ إذا أنا شككت أن أنظر فيه؟ قال: لا ، ولكنّك تريد أن تذهب بالشكّ الذي وقع في نفسك. قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، قال: تنقض الصلاة، وتعيد إذا شككت في موضعٍ منه ثم رأيته، وإن لم تشكّ، ثمّ رأيته رطباً قطعت الصلاة، وغسلته، ثمّ بنيت على الصلاة، لأنّك لا تدري، لأنّه شيء أوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ)(٢) .
واعلم: أنّ الروايات المتعلّقة بهذا الباب بحسب الفروع المستخرجة منها مختلفة، والفتاوى - أيضاً - من أجلها اختلفت.
فمنها : صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليهالسلام : (الدم في الثوب يكون عليّ وأنا في الصلاة قال: اذا رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه، وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ما لم تزد على مقدار الدرهم)(٣) .
____________________
(١) في « ط ١ »: « نطق » وهو تصحيف.
(٢) التهذيب: باب تطهير البدن والثياب من النجاسات ح ٨، ج ١، ص٤٢١ و ٤٢٢.
(٣) وسائل الشيعة: ب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم، ح ٦، ج ٢، ص ١٠٢٧. مع اختلاف يسير.
ومنها: صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللّهعليهالسلام : (في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين، ثمّ علم به، قال: عليه أن يبتدئ الصلاة. قال: وسألهعليهالسلام عن رجلٍ يصلّي وفي ثوبه جنابة أو دم، حتى فرغ من صلاته، ثمّ علم به، قال: مضت صلاته ولا شيء عليه)(١) .
ومنها: صحيحة زرارة: (وإن أنت نظرت (في ثوبك)(٢) فلم تصبه، ثمّ قد صليت فيه، ثم رأيت بعد فلا إعادة عليك)(٣) .
ومنها: رواية صيقل قال: (قلت له: رجل أصابه جنابة بالليل، واغتسل، فصلّى، فلما أصبح نظر فاذا في ثوبه جنابة، قال: الحمد للّه الذي لم يدع شيئاً إلاّ وقد جعل له حدّاً، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئاً فلا إعادة عليه، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة)(٤) .
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار، عن ميسر، قال: (قلت لأبي عبد اللّهعليهالسلام : آمر الجارية فتغسل ثوبي من المنيّ، فلا تبالغ في غسله، فأصلّي فيه فاذا هو يابس قالعليهالسلام : أعد صلاتك، أما (أنّك)(٥) لو كنت أنت غسلته لم تكن عليك إعادة)(٦) .
والذي ينبغي تقديمه في هذا الباب أوّلاً هو الأصل، ثمّ الرجوع الى خصوصيّات الأدلّة.
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب عدم وجوب الاعادة على من صلى وثوبه أو بدنه نجس، ح ٢، ج ٢، ص ١٠٥٩.
(٢) أثبتناها من المصدر لضرورتها.
(٣) وسائل الشيعة: ب عدم وجوب الاعادة على من نظر في الثوب قبل الصلاة ح ٢، ج ٢، ص ١٠٦٢.
(٤) وسائل الشيعة: ب عدم وجوب الاعادة على من نظر في الثوب قبل الصلاة ح ٣، ج ٢، ص ١٠٦٢، مع اختلاف يسير.
(٥) أثبتناها من المصدر.
(٦) وسائل الشيعة: ب ان من امر الغير بغسل ثوب نجس بالمني فلم يغسله ح ١، ج ٢، ص ١٠٢٤، مع اختلاف يسير.
فنقول: من الأخبار التي يستفاد منها الأصل قولهعليهالسلام : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة »(١) والكلام فيه في مواضع:
الأوّل: ظاهر العموم أنّه لا خصوصيّة لإسباب الخلل في عدم الإعادة، وأنّها منفيّة مطلقاً، ولكنّ العمد لكون نفي الإعادة مع الخلل المستند اليه منافياً (لوقوع الخلل المفروض ثبوته)(٢) لفرض الجزئية والشرطيّة، المستفاد من قولهعليهالسلام : « إلاّ من خمسة » غير داخلٍ فيه.
ولكنّ ظاهر الأصحاب، الاتّفاق على أنّ الجهل بالحكم ولو كان عن نسيان لا يكون عذراً مطلقاً.
والقول بالاجزاء مع تغيّر الرأي مختصّ بصورة عدم العلم، بخلاف الرأي السابق، كما تشهد به ملاحظة أدلتهم وعنواناتهم.
وأمّا الجهل بالموضوع فالأمر فيه مشكل، من حيث (أنّ)(٣) ظاهر (كلمات)(٤) كثير من الأصحاب أنّه لا يعذر(٥) من أجله، كما تشهد به كلماتهم في الفروع المتفرّقة في أبواب الجماعة، وهذا الباب، وأبواب مقدّمات الصلاة.
فإنّا نراهم يلتمسون للاجزاء في مواقع الجهل بالموضوع الى دليلٍ خاصّ في تلك المسألة، ولا نراهم يحكمون بالاجزاء في موارد ينحصر دليلها(٦) في عموم هذه القاعدة وإن كانوا يذكرونها في المواقع التي يحكمون بالاجزاء في طيّ الأدلّة، والالتزام بخروجه يخرج الرواية عن صحّة التمسّك بها في مواقع السهو والنسيان، الذي هو ديدن أهل الاستدلال، لكونه مع خروج نسيان الحكم، وجهله من التخصيص
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب عدم وجوب الاعادة على من نسي القراءة ح ٥، ج ٤، ص ٧٧٠.
(٢) هذه الزيادات اثبتناها من « ط ٢ ».
(٣) و (٤) هذه الزيادات اثبتناها من « ط ٢ ».
(٥) في « ط ٢ »: « لا يعتذر » والظاهر أن ما أثبتناه هو الصحيح.
(٦) لعودة الضمير الى الموارد وفي « ط ٢ » هكذا « في موردٍ انحصر دليله ».
الأكثر الذي لا يبقى معه أصالة العموم، إلاّ أن يدّعى انصرافه الى الخلل الحاصل بالنسيان ولو بضميمة فهم الأصحاب، وهو أيضاً مشكل وان لم يكن بعيداً.
وهل المناط في السهو كونه سبباً للترك وإن كان الساهي جاهلاً بالحكم، أو يعتبر فيه كونه بحيث لو لم يكن لكان آتياً به للزومه الأقرب الأوّل للعموم وإطلاق الأدلّة الآتية. لا يقال: أمّا العموم فقد عرفت وهنه، وأمّا الاطلاقات فهي منصرفة الى غير هذه الصورة.
لأنّا نقول: لا أظنّ أنّ أحداً من العلماء يتوقّف في التمسك بهذا الحديث في باب السهو، ولو سها عن نذره فعل مستحبّ فتركه وجب الإعادة عليه إن تبيّن له وجوبه، لأنّه عامد. ولو نشأ سهوه عن التهاون في التحفّظ، لأنّه يراه مستحباً احتمل وجوب الإعادة، لرجوعه الى عدم البناء على الفعل، إلاّ مع بقاء الذكر اتّفاقاً، فيكون تركه عن اختياره(١) ، ولا يكون السهو تمام السبب، ويحتمل العدم تمسّكاً بالعموم، وفيه إشكال.
الثاني: الظاهر من الإعادة هو الاتيان ثانياً بعد تمام الأوّل، فلا ينفي الاستئناف في الأثناء، ولكنّ استعماله في الأعمّ شائع في الأخبار، وفي لسان المتشرّعة، مضافاً الى شهادة صدر الحديث، وهو قولهعليهالسلام :« القراءة(٢) سنة » فأنّه ظاهر في أنّ تركه عن سهو لكونه سنّةً لا يوجب النقص حين حصوله، لا أنّه مراعى بإتمام الصلاة.
هذا - كلّه - مضافاً إلى الإجماع على عدم الفرق في كثيرٍ من المواضع.
الثالث: هل يستفاد من الحديث ركنيّة الركوع والسجود بالمعنى الأخصّ وهو كون زيادتهما - عمداً أو سهواً - مضرّاً، أم لا؟ فيه إشكال، من أنّ الإعادة - عقلاً - لا تصحّ إلاّ مع النقص، وإن كان حاصلاً بالزيادة المانعة فهي - حينئذٍ - داخلة في
____________________
(١) في « ط »: « اختيار » وما أثبتناه كما في « ط ٢ » وهو الأظهر.
(٢) وسائل الشيعة: ب ٢٧ عدم وجوب الاعادة على من نسي القراءة ح ١، ج ٤، ص ٧٧٠.
المستثنى منه.
فكأنّ المعنى: لا إعادة من قبل النقص الحاصل في الصلاة، بسبب حصول ما يعتبر عدمه، أو عدم ما يعتبر حصوله إلاّ من عدم للخمسة، ومن أنّ نقص الجزء وزيادته اعتباران متواردان عليه، يكون كلّ واحدٍ منهما موجباً للإعادة.
غاية ما في الباب: أنّ أحدهما للجزئية الذاتيّة، والآخر بجعلٍ ثانويّ، وهو كون عدم زيادته شرطاً، فالإعادة المتوهّمة وجوبها من قبل الجزء منشؤه أمران، فاذا استثني الجزء باعتبار الإعادة الحاصله من قبله خرّج زيادته عن المستثنى منه.
والحاصل: أنّ للزيادة اعتبارين:
أحدهما: كون عدمها معتبراً في الصلاة.
والآخر: كونها من صفات الاجزاء، تكون هي موجبة لسببها للإعادة، فتكون سببيّة الاجزاء للإعادة من وجهين: نقصها، وزيادتها، وهي بالاعتبار الأوّل تكون في قبال الأجزاء.
قلت: إنّ هذه دقّة جيّدة، لكنّ ظهور الرواية فيها مشكل.
ويمكن أن يقال: إنّ الرواية لا تشمل العدميّات المعتبرة، فلا حكم لها على الزيادة، فيبقى تحت عموم أصالة عدم الاجزاء - عقلاً - إن قلنا به.
والحاصل: أنّه إن ثبت عموم يدلّ على إبطال الزيادة مطلقاً لم تكن الرواية حاكمةً عليه في زيادة الأركان: إمّا لدخولها في المستثنى، أو لعدم دخوله في المستثنى منه أوّلاً.
هذا، ولكنّ الأمر هيّن من حيث أنّ الأمر في زيادة الأركان أوضح من ذلك.
الأمر الرابع: لو جهل أن سبب النقص عمد، أو سهو فالتمسّك بالعموم مبنيّ على حكم العمومات في الشبهة المصداقيّة.
إلاّ أن يقال: إنّ الخارج هو المعلوم كونه عن عمدٍ، وفيه ما فيه.
الخامس: لو كان(١) ملتفتاً الى النسبة الحكميّة الناقصة بين الجزء ووجوبه، ولم يكن مذعناً به، فاعتقد خلافه قطعاً، أو لدليل، أو أصلٍ كان ناسياً للحكم.
وأمّا الذاهل عن النسبة فهو ساهٍ للموضوع، إذ ليس معنى سهو الموضوع أن تكون صورة الجزء عازبة عن ذهنه، بل يعمّ عزوبها، وعزوب صورة المحمول، وصورة النسبة، فافهم.
وأمّا الشاكّ في النسبة، الذي يترك الجزء من غير استناد الى شيء فهو عامد.
هذا كلّه حكم الأصل الثانويّ، وأمّا الأصل الأوّليّ: فأمّا في الناسي فقد يقال: إنّه عدم الاجزاء، لأنّه يختصّ بخطاب، فيكون حكمه حكم الذاكر.
ويرد عليه: أولاً منع الملازمة لجواز أن لا يكون له حكم أصلاً، لا بالتامّ المغفول عنه، ولا بالناقص الذي أتى به غفلةً، بل هو كذلك، لأنّه غير قادرٍ على المغفول عنه، وغير قابل للخطاب بالناقص، فتوجّه الخطاب به اليه لغو وقبيح.
وإن اريد من الخطاب صرف الاقتضاء والمصلحة فنسبة الإمكان الى الناقص والتامّ(٢) سواء.
لا يقال: إطلاق الأمر ما يقتضي عموم الجزئية للحالين، وعدم القدرة إنّما يوجب سقوط الخطاب، لا الاقتضاء، فاذا زالت الغفلة المانعة يعود الخطاب فعليّاً، كما هو الشأن في كلّ عاجزٍ ارتفع عجزه.
لأنّا نقول: إنّا نفرض الكلام في مقامٍ ليس دليل على عموم الجزئية من عمومٍ أو إطلاق.
لا يقال: بعد الإجماع على أنّ كل أحدٍ لا محالة له خطاب، كأنّ خطاب الناسي كخطاب الذاكر، لعدم إمكان اختصاصه بخطاب، فيكون النسيان كالجهل
____________________
(١) في الأصل: زيادة « الحكم كذا » وهي زيادة غير مناسبة، ولم توجد في « ط ٢ »، ولذا لم نذكرها حفاظاً على وحدة السياق.
(٢) في نسختي الأصل « التمام » وهو تصحيف.
مانعاً عن التنجّز، بل هو نوع من الجهل.
لأنّا نقول: دعوى الإجماع بالنسبة الى الجهل بالموضوع ممنوعة.
نعم، نسيان الحكم لا يوجب اختلاف الحكم، وإلاّ لزم التصويب الباطل بالإجماع.
وملخص الكلام: أنّا نشك بعد ارتفاع العذر أنّ الناسي صار مكلّفاً بغير ما أتى به نسياناً، والأصل عدمه، وثبوت الاقتضاء بالنسبة الى الجزء الفائت لا دليل عليه، فالأصل البراءة عنه كما هو الشأن في كلّ مورد دار الأمر فيه بين الأقلّ والأكثر.
لا يقال: إنّا نستصحب بقاء الإرادة الذاتيّة، التي كانت ثابتةً في حال النسيان.
لأنّا نقول: المعلوم منها - وهي المتعلّق بالقدر المشترك بين الأقلّ والأكثر - مقطوع الامتثال، والزائد مشكوك الحدوث، فالأصل عدمه والبراءة عنه.
هذا، مع أنّ لنا أن نتصوّر للناسي خطاباً يختصّ به، بأن يخاطب الناسي في ضمن مطلق الإنسان بالصلاة، ويشرح له الاجزاء والشرائط على ما هي عليه من العموم والاختصاص بالذاكر، وحينئذٍ، فإن لم يلتفت أوّل الأمر الى جزءٍ فلا محالة ينوي الأجزاء المطلقة، المفصّلة في ذهنه بعنوان أنّها عين الصلاة.
وإن التفت، والتفت(١) الى أنّ من تلك الأجزاء ما يختصّ بالذاكر ينوي الإتيان بالعبادة بحسب ما يجب عليه، على حسب الحالة الطارئة عليه، فيكون داعية المرتكز في ذهنه الأمر الواقعيّ الذي تصوّره بعنوان الإجمال، واعتقاد أنّه لا يعرض عليه النسيان لا يضرّ بالنيّة كما لا يخفى (فتأمّل)(٢) .
هذه خلاصة ما أفاد سيّد مشائخنا - رضوان اللّه عليه - في الدرس في النجف
____________________
(١) أثبتناها لما هو الظاهر، وكما في « ط ٢ ».
(٢) أضفناها من « ط ٢ ».
الأشرف في مسجد الهنديّ، شكر اللّه سعيه وأجزل مثوبته.
وأما الجاهل بالموضوع: كمن جهل كونه مكشوف العورة، أو أنّ لباسه ممّا لا يؤكل لحمه، جهلاً مركباً أو غير مركّب عمل فيه بمقتضى أصلٍ ظاهري، فحكمه في الاجزاء، وعدمه حكم الناسي بحذافيره.
وأمّا الجاهل بالحكم - فلا محالة - حكمه الواقعيّ مع العالم سواء، ويكون الاجزاء في حقّه محتاجاً الى دليلٍ قطعيً، بل يشكل تصوّره في حقّه إلاّ ببعض (من)(١) الوجوه، التي ليس هنا محلّ تعرّضها.
اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم، أنّ الشهيد(٢) -قدسسره - احتمل وجوب الإعادة على الجاهل اذا كان تاركاً للفحص، وقد تمسّك برواية زرارة(٣) الأخيرة، ورواية صيقل(٤) ، والرواية الأخيرة سندها قويّ جداً كالاولى، وتوافقهما في الدلالة مرسلة الصدوق: (أنّه روى في المنيّ، أنّه إن كان الرجل (جنباً)(٥) حيث قام (و)(٦) نظر وطلب فلم يجد شيئاً فلا شيء عليه، وإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله، ويعيد صلاته)(٧) . ولكنّ الأخيرة مرسلة، ورواية صيقل غير نقيّة(٨) السند، والرواية الاولى في دلالتها ضعف، لاحتمال أن يكون النظر بياناً لطريق عدم الإصابة، لا شرطاً في الحكم.
وأمّا رواية ميسرة(٩) فيمكن حملها على كونها متّهمة، لا يجوز الإتكال على
____________________
(١) اضيفت من « ط ٢ ».
(٢) الذكرى: حكم النجاسات ص ١٧، س ١٧.
(٣) التهذيب: باب تطهير البدن والثياب من النجاسات ح ٨، ج ١، ص ٤٢١ و ٤٢٢.
(٤) وسائل الشيعة: ب عدم وجوب الاعادة على من نظر في الثوب قبل الصلاة ح ٣، ج ٢، ص ١٠٦٢.
(٥) و (٦) أضفناهما من المصدر لاستقامة المتن.
(٧) من لا يحضره الفقيه: باب ما ينجّس الثوب والجسد، ح ١٦٧، ج ١، ص ٧٢.
(٨) في الأصل « نقي » وهي تصحيف.
(٩) وسائل الشيعة: ب ان من امر الغير بغسل ثوب نجس بالمني فلم يغسله ثم صلى ح ١، ج ٢، ص ١٠٢٤.
إخبارها، ولا حمل فعلها على الصحة، وفيه بعد، لأنّ الظاهر أن قول: « ذي اليد » معتبر مطلقا، وكذلك « فعل المسلم » يحمل على الصحّة مطلقاً.
ولكن يمكن أن يقال: رواية الجارية أعمّ من صورة حصول العلم، أو الوثوق الذي لا يرى معه مجالاً للفحص، وغيرها من الصور، وحملها على غير هذه الصورة لا وجه له، كما أنّ الحكم باعتبار الفحص تعبّداً محضاً في سقوط القضاء بعيد.
إلاّ أن يقال: إنّ قولهعليهالسلام « أما لو كنت أنت غسلته » قرينة على عدم حصول الوثوق بصحة عمل الجارية.
وكيف كان، فحملها على الاستحباب، مع عدم عمل المشهور به، ومعارضتها بقولهعليهالسلام - في رواية زرارة(١) الطويلة بعد السؤال عن وجوب النظر - : « لا، ولكن تريد أن تذهب بالشكّ الذي وقع في نفسك » الظاهر في أن فائدة النظر منحصر في رفع الشك، فلا دخل له في سقوط الإعادة، خصوصاً مع سبق تعليل عدم الإعادة، بأنّه لا ينبغي نقض اليقين بالشك إن كان فرض الكلام في حدوث العلم بكون النجاسة في أثناء الصلاة الظاهر في أنّ مناط الاجزاء هو ذلك، لا هو مع سبق النظر غير بعيدٍ إن لم يكن متعيّناً.
ويؤيّده عموم « لا تعاد »(٢) وأصالة البراءة عن القضاء، بل وأصالة البراءة عن الإعادة بأن يقال: المعلوم اشتراط الصلاة بالطهارة الثابتة عقلاً أو شرعاً، وكونها واقعيّةً لم يعلم شرطيّتها، فالاصل براءة الذمّة عنها، فتأمل.
ولو تبيّن النجاسة في أثناء الصلاة فمقتضى ذيل صحيحة زرارة() الطويلة، ورواية أبي بصير(٤) السابقة وجوب الإعادة، وحمل الأخيرة على صورة عدم التمكّن من
____________________
(١) التهذيب: باب تطهير البدن والثياب من النجاسات ح ٨، ج ١، ص ٤٢١ و ٤٢٢.
(٢) وسائل الشيعة: ب عدم وجوب الاعادة على من نسى القراءة ح ٥، ج ٤، ص ٧٧٠.
(٣) التهذيب: باب تطهير البدن والثياب من النجاسات ح ٨، ج ١، ص ٤٢١ و ٤٢٢.
(٤) وسائل الشيعة: ب عدم وجوب الاعادة من صلى وثوبه أو بدنه نجس ح ٢، ج ٢، ص ١٠٥٩.
نزع الثوب في أثناء الصلاة على وجه لا يلزم منه إبطال الصلاة وإن كان ممكناً.
ولكنّ رواية زرارة نص في غير هذه الصورة، ولا تعارضه رواية محمد بن مسلم، لجواز حملها على كون الدم أقلّ من الدرهم.
كما يشهد به قولهعليهالسلام فيها: « ما لم يزد على مقدار الدرهم »(١) .
وأمّا تعليل رواية زرارة، فمع ما فيه من الإشكال لا يعارض الصحيحة الناصّة.
فإن قلت: هذه الروايات مهجورة لم تعمل بها الطائفة.
قلنا: ظاهر العبارة المحكيّة عن الشيخ في المبسوط(٢) : (إنّ وجوب الإعادة مع تبيّن النجاسة في الأثناء من المسلّمات).
وكيف كان فالمسألة قوّت(٣) الإشكال جداً، والاحتياط بالتمام ثمّ الإعادة طريق النجاة، كما أمر سيّد مشائخنا -رحمهالله - في كتبه الفتوائيّة.
واعلم، أنّ صريح الشرائع(٤) إلحاق موضع الجبهة بها في عدم وجوب الإعادة مع تبيّن النجاسة، ولعلّ وجهه، مضافاً الى عموم « لا تعاد » - أنّ طهارة محلّ السجود ليس شرطاً مستقلاً - اعتبر في قبال طهارة البدن، كما يكون ستر العورة مثلاً، بل طهارة اللباس والبدن وموضع الجبهة شرط واحد.
فيفهم من أدلّة الاجزاء في الثوب الاجزاء في موضع الجبهة، كما هو كذلك بالنسبة الى البدن، فافهم.
ويؤيّده عموم التعليل في صحيحة زرارة(٥) ، وأصالة البراءة من القضاء
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم ح ٦، ج ٢، ص ١٠٢٧.
(٢) المبسوط : في حكم الثوب والبدن والارض اذا اصابته نجاسة وكيفية تطهيره ج ١، ص ٩٠.
(٣) في الأصل « قوي » وهو تصحيف والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الارجح.
(٤) شرائع الاسلام: في الخلل الواقع في الصلاة ج ١، ص ١١٣.
(٥) التهذيب: باب تطهير البدن والثياب من النجاسات، ح ٨، ص ٤٢١ و ٤٢٢.
والإعادة بالتقريب المتقدّم.
إلاّ أن يقال: إنّ المستفاد من مجموع أدلّة اجتناب النجاسات في الصلاة اشتراطه واقعاً، وأنّ مواقع سقوط الإعادة إجزاء تعبّدي ، وهو غير بعيد ٍ، بل قويّ ، واستفادة عموم الاجزاء من الأخبار بالتقريب المتقدّم ممنوع، وعموم « لا تعاد »(١) قد عرفت الكلام فيه، ودعوى الاجماع(٢) هنا قبيحه.
فالقول بعدم سقوط الإعادة، بل القضاء قويّ جداً لاطلاق الاشتراط المفهوم من الأدلّة - كما عرفت - وفاقاً للجواهر(٣) ونجاة العباد(٤) ، وتقرير شيخنا شيخ الطائفة(٥) ، وسيّد مشائخنا - رضول اللّه عليهم -.
ولو ضاق الوقت عن تحصيل الثوب الظاهر ففي وجوب الصلاة مع الثوب النجس، أو الصلاة عارياً، أو التخيير بينهما وجوه: الأقوى عند المشهور - كما قيل - : هو الثاني.
والكلام هنا: تارةً في حكم المسألة بحسب القواعد، واخرى فيه بملاحظة الأخبار الخاصّة المتعلّقة به.
واعلم: أنّ محلّ الكلام ما لو أمن من الناظر المحترم ولو بالصلاة جالساً. وأمّا معه فلا إشكال في وجوب الستر بالثوب النجس والصلاة معه.
فنقول: الأمر دائر بين فوات أحد الشرطين: طهارة لباس المصلي، و(٦) ستر عورته، وليس لأحدهما بدل، فيجب الحكم بالتخيير.
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب عدم وجوب الاعادة على من نسى القراءة ح ٥، ج ٤، ص ٧٧٠.
(٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٢٧.
(٣) جواهر الكلام: في وجوب الاعادة على الناسي ج ٦، ص ٢١٥.
(٤) نجاة العباد: ص ٦٤، في المبحث الثالث من أحكام النجاسات.
(٥) لم نعثر عليه.
(٦) في نسختي الأصل « أو » والظاهر تصحيف، وأثبتناه لأنّه أحد الشرطين والترديد لا يكون إلاّ بعد تعيينهما.
لا يقال: يدور الأمر بين فوات الركوع والسجود، بل القيام في بعض المواضع وستر العورة، وبين فوات طهارة اللباس.
ولا ريب، أنّ فوات الثاني أولى.
لأنّا نقول: يختلف ركوع المصلّي وسجوده وقيامه باختلاف حالاته، وهي بالنسبة الى من وجبت عليه الصلاة عارياً إيماء وقعود.
والحاصل أنّ وجوب التامّ منها مقيّد بعدم وجوب الصلاة عارياً. كذا أفاد به بعض مشائخنا(١) ، وفيه نظر؛ فأنّ وجوب الإيماء لسقوط الستر بالعجز لا يلازم سقوطه مع التمكن منه، ودوران الأمر بينه وبين طهارة اللباس.
والحاصل: أنّ انتفاء الدوران بين الطهارة والركوع (التامّ)(٢) أنّما يتمّ اذا علم أنّ الركوع التامّ مقيّد - شرعاً - بعدم سقوط الستر ولو بترجيح شرط آخر عليه، وهو ممنوع.
لا يقال: شرط الستر أن يكون بالطاهر، فاذا تعذّر سقط المشروط لانتفاء شرطه، فتعيّن الصلاة عارياً.
لأنّا نقول: طهارة لباس المصلي شرط مستقلّ، ولذا لو تستّر بطاهر لم يسقط وجوب طهارة ما عليه.
ودعوى الجمع بين الاستقلال، وشرطية الستر، مع بعدها مدفوعة بمخالفتها لظاهر أدلّة اجتناب النجس، بل الظاهر أنّ كلّ ما يعتبر في اللباس من عدم كونه حريراً محضاً أو غير ذلك شرط مستقلّ، لا أنّه شرط في شرط الستر، فافهم.
لا يقال: إنّ من أمن من الناظر المحترم، ولم يقدر على الساتر وجب عليه الصلاة قائماً مومياً، ولا يكون ذلك إلاّ تعبداً، خصوصاً اذا قلنا: بأنّ ستر العورة باليدين لا يجب عليه، فيكشف ذلك عن كون الركوع التامّ مقيّداً بوجوب ستر العورة.
____________________
(١) الجواهر: في حكم المصلي اذا انحصر ثوبه في النجس ج ٦، ص ٢٤٩.
(٢) هذه الزيادة من « ط ٢ ».
لأنّا نقول: أوّلاً يمنع(١) ذلك، بل يحتمل وجوب الركوع التامّ، حينئذٍ سلمنا.
ولكن يمكن أن يكون ذلك لأجل ستر الدبر (بالاليين، وسقوط ستر القبل باليدين لو سلّمناه لا يدّل على سقوط ستر الدبر)(٢) .
والحاصل: أنّ الالتزام بالإيماء في الركوع والسجود هنا إن قلنا بسقوط الستر، وكذا في الغرض الذي ذكره المورد لا يدلّ على كون الركوع التامّ مقيّداً بالستر، بل لعلّه(٣) لرعاية ستر الدبر بالاليين(٤) ، فلابدّ لمن يريد تقديم الطهارة على الستر أن يلاحظ حال الركوع في مقام الدوران، ومعه يشكل الحكم بتقديم رعاية الطهارة، خصوصاً مع ما نشاهد من الأخبار الواردة في باب السهو الدالّة على اهتمام الشارع في حفظ الركوع والسجود، فافهم.
والحاصل: أنّ الحكم بالتخيير، بل وتعيّن الصلاة عارياً - لولا الأخبار الخاصّة - مشكل، فلنرجع الى حكم المسألة بحسب الأخبار.
فنقول: مقتضى بعض الأخبار، مضافاً الى إطلاق النهي عن الصلاة في النجس وجوب الصلاة عارياً كمضمرة سماعة، قال: (سألتهعليهالسلام : عن رجلٍ يكون في فلاة من الأرض، وليس عليه إلاّ ثوب واحد، وأجنب فيه، وليس عنده ماء. كيف يصنع؟ قال: « يتيمّم، ويصلّي عرياناً قاعداً، يوميء إيماءً »)(٥) .
وفي روايةٍ اخرى مثل الاولى، إلاّ أنّ فيها: « يصلّي عرياناً قائماً، يوميء
____________________
(١) في « ط ١ » نمنع، ولكنّ الظاهر وما في « ط ٢ » هو الأصحّ.
(٢) هذه الزيادة أضفناها من « ط ٢ ».
(٣) في « ط ١ »: (لعلمه) تصحيف، وما أثبتناه هو الظاهر وكما في (ط ٢).
(٤) في أصل « ط ١ »: « بالألية » وما أثبتناه من « ط ٢ ».
(٥) وسائل الشيعة: ب وجوب طرح الثوب النجس مع الامكان ح ١، ج ٢، ص ١٠٦٨.
إيماءاً »(١) .
وروى الحلبيّ، عن أبي عبد اللّهعليهالسلام : (في رجلٍ أصابته جنابة وهو بالفلاة، وليس عليه إلاّ ثوب واحد، واصاب ثوبه منيّ، قال: « يتيمّم، ويطرح ثوبه، ويجلس مجتمعاً، فيصلّي فيوميء إيماءً»(٢) .
وبأزاء هذه الروايات، روايات اخر صريحة في جواز الصلاة مع الثوب، بل في بعضها النهي عن الصلاة عرياناً، وفي بعضها التقييد بالاضطرار.
كصحيحة الحلبيّ: « في الثوب الذي أصابه المنيّ يصلّي فيه »(٣) .
وفي صحيحة علي بن جعفرعليهالسلام عن أخيهعليهالسلام : عمّن ليس عنده إلاّ ثوب، كلّه أو بعضه دم، وفيه: « إن لم يجد ماءً صلّى فيه ولم يصلّ عرياناً »(٤) .
وفي صحيحة الحلبي: عن الرجل يجنب في ثوب، أو يصيبه البول، وليس معه ثوب غيره. قال: « يصلي فيه اذا اضطرّ اليه »(٥) .
فربّما يجمع بينها بحمل أخبار الجواز على الاضطرار بشهادة هذه الصحيحة الأخيرة، حملاً للاضطرار فيه على الاضطرار الخارجي، لا الاضطرار من قبل الصلاة لوجوبها مع الستر، وظهورها فيما ادّعوه لا يخلو عن خفاء.
وربّما يجمع بينها بالتخيير، فإن اريد منه الواقعي فلا يلائم صحيحة علي بن جعفر(٦) . وإن اريد ظاهراً فهو فرع التكافؤ في الأخبار.
وربما يجمع بينها بحمل أخبار إيجاب الصلاة عرياناً على الأمن من الناظر
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب وجوب طرح الثوب النجس مع الامكان ح ٣ ، ج ٢، ص ١٠٦٨.
(٢) وسائل الشيعة: ب وجوب طرح الثوب النجس مع الامكان ح ٤ ، ج ٢، ص ١٠٦٨.
(٣) وسائل الشيعة: ب جواز الصلاة مع النجاسة اذا تعذرت الازالة ح ١، ج ٢، ص ١٠٦٦.
(٤) وسائل الشيعة: ب جواز الصلاة مع النجاسة اذا تعذرت الازالة ح ٥، ج ٢، ص ١٠٦٧.
(٥) وسائل الشيعة: ب جواز الصلاة مع النجاسة اذا تعذرت الازالة ح ٧، ج ٢، ص ١٠٦٧.
(٦) وسائل الشيعة: ب جواز الصلاة مع النجاسة اذا تعذرت الازالة ح ٥، ج ٢، ص ١٠٦٧.
المحترم، (لأنّ تقييدها بذلك قطعيّ، فيكون أخصّ مطلقاً من أخبار الجواز مع الثوب النجس. فتقييدها بصورة عدم الأمن من الناظر المحترم)(١) .
وهذا وإن كان موافقاً لقواعد الجمع مشكل، من حيث أنّه يوجب حمل أخبار الجواز على الفرد النادر، فأنّ عدم التمكّن من الصلاة قاعداً مجتمعاً - فيبقى مستوراً - بعيد، لا يقع إلاّ نادراً.
هذا، ولكنّ الأخذ بالجمع الأوّل لموافقته للمشهور، مع تقييد أخبار الصلاة عرياناً بصورة عدم الاضطرار، فيصير أخصّ من أخبار المنع عن الصلاة عرياناً فيقدّم غيره بعيد.
ولو فرضنا بعد هذا الجمع أيضاً كان العمل عليه، لأنّ أخبار الصلاة في الثوب النجس وإن كانت أقوى سنداً إلاّ أنّ موافقة المشهور أولى، لأنّ الخبر الموافق لهم أقوى من الآخر، والواجب بعد التعارض الرجوع الى أقوى الدليلين، ثمّ في تقديم القيام على القعود مطلقاً، أو مع الأمن من الناظر المحترم وجهان: لعلّ الثاني أولى في عاجل النظر، فتأملّ.
وهل يتمّ الركوع والسجود إن صلّى قائماً ؟ وجهان: لعلّ الأرجح العدم. وهاتان المسألتان محتاجتان الى التأمّل.
مسألة: لو شكّ في كون اللباس طاهر فالأصل طهارته، ولو شكّ في كونه ميتةً فيحتمل أن يقال: كذلك، لأنّ المذكّى والميتة موضوعان متباينان.
ويحتمل أن يقال: إنّ الأصل عدم التذكية، ويحتمل أن يقال: الأصل عدم الموت حتف الانف.
ومبنى الإشكال: أنّ المقتضي في الحيوان على بقاء طهارته وكون موته حتف أنفه منجساً له، وأمّا المذكّى فطهارته الأصليّة باقية، أو أنّ التذكية رافعة لأثر الموت، والأقوى هو الأخير، كما هو المستفاد من استثناء التذكية. ولتنقيح هذا
____________________
(١) هذه الزيادة أضفناها من « ط ٢ ».
المبحث مقام آخر.
وعلى هذا، فيفتقر(١) في الحكم بالطهارة في الشبهات الموضوعيّة الى أصلٍ، أو أمارة حاكمةٍ على أصالة عدم التذكية.
وأمّا على الوجهين: فيكفي الشبهة في الحكم بالطهارة، ويفتقر(٢) الحكم بالنجاسة الى أمارةٍ، أو أصلٍ حاكمٍ على أصالة الطهارة.
اذا عرفت ذلك فنقول: قد ثبت أمارات نوعيّة حاكمة على أصالة عدم التذكية، وهي امور(٣) : نبدأ أوّلاً بذكر أخبار الباب في الجملة تيمّناً.
فنقول: [ ١ ] منها:
ما رواه أحمد بن محمد ابن أبي نصر، وسليمان بن جعفر الجعفري، عن العبد الصالحعليهالسلام : سألته عن الرجل يأتي السوق، فيشتري جبة (فراء)(٤) ، لا يدري أذكيّة (هي)(٥) أم غير ذكيّةٍ، أيصلّي فيها؟ فقال: « نعم ليس عليكم ». المسألة أنّ أبا جعفرعليهالسلام كان يقول: « إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم، لجهالتهم أنّ الدين أوسع من ذلك »(٦) .
و [ ٢ ] روى اسحاق بن عمّار، عن العبد الصالحعليهالسلام أنّه قال: « لا بأس بالصلاة في الفراء اليمانيّ، وما صنع في أرض الاسلام، قلت : فإن كان فيها غير أهل الاسلام ؟ قال: اذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس »(١) .
ظاهر الرواية الاولى: أنّ ما كان في سوق المسلمين يجوز شراؤه من أيّ رجلٍ كان ويحكم بطهارته، سواء كان من صنع بلاد الاسلام، أو غيره.
____________________
(١) و (٢) ما في « ط ١ » كان تصحيفاً، وما في المتن « ط ٢ » هو الأظهر.
(٣) في « ط ١ » عبارة مبهمة، وما أثبتناه كما في « ط ١ ».
(٤) و (٥) أضفناهما من « ط ٢ ».
(٦) وسائل الشيعة: ب طهارة ما يشتري من مسلم ومن سوق المسلمين ح ٣، ج ٢، ص ١٠٧١، ومن لا يحضره الفقيه: فيما يصلى فيه وما لا يصلى فيه ح ٧٩١، ج ١، ص ٢٥٧.
(٧) وسائل الشيعة: ب طهارة ما يشتري من مسلم ومن سوق المسلمين ح ٥، ج ٢، ص ١٠٧٢.
وظاهر الرواية الثانية: أنّ المصنوع في بلدٍ يكوّن أغلبها المسلمون يجوز شراؤه وإن كان في سوق الكفار، أو من يد الكافر.
وروى اسماعيل بن عيسى، قال: سألت أبا الحسنعليهالسلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوقٍ من أسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته اذا كان البائع مسلماً غير عارفٍ ؟ قال: « عليكم أنتم أن تسألوا اذا رأتيم المشركين يبيعون ذلك، واذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه »(١) .
وظاهر هذه الرواية: أن ما في يد المسلم الباني على أنّه مذكّى وطاهر محكوم بالطهارة وإن كان ممّن يرى تذكيته بالدباغ. بل يمكن أن يقال: إنّ المجهول كونه كافراً أو مسلماً يجوز الأخذ منه، بناءً على أنّ المراد من رؤية بيع المشركين العلم بأنّ البائع مشرك، ويكون قولهعليهالسلام : « اذا رأيتم يصلون فيه » بعض مفهوم القضيّة الاولى، وفيه نظر.
و [ ٣ ] روى النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّهعليهالسلام : أنّ أمير المؤمنينعليهالسلام سئل عن سفرةٍ وجدت في الطريق، مطروحة بكثر(٢) لحمها وجبنها وبيضها، وفيها سكّين، فقال أمير المؤمنينعليهالسلام : يقوّم ما فيها، ثمّ يؤكل، لأنّه يفسد وليس له بقاء، فاذا جاء طالبها غرموا له الثمن. قيل له: يا أميرالمؤمنين، لا يدري سفرة مسلم، أم سفرة مجوسيّ؟ فقال: « هم في سعةٍ حتى يعلموا »(٣) .
وفي كثير من الروايات: « ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه »(٤) . إلاّ أنّ في بعضها السؤال عمّا في سوق المسلمين.
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب طهارة ما يشتري من مسلم ومن سوق المسلمين ح ٧، ج ٢، ص ١٠٧٢.
(٢) في « ط ١ »: « لكثير خ ل »، وفي « ط ٢ »: « يكثر ».
(٣) وسائل الشيعة: ب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين ح ١١، ج ٢، ص ١٠٧٣.
(٤) وسائل الشيعة ب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين ح ٤، ج ٢، ص ١٠٧٢.
والظاهر وجوب حمل مطلقاتها على ذلك، جمعاً بينها وبين قولهعليهالسلام : « اذا كان الغالب عليها المسلمين » فإنّ الحكم في صورة عدم الغلبة من أحد الطرفين بالنجاسة - كما يستفاد منه - ينافي كون حكم الشكّ بما هو شكّ الطهارة، مضافاً الى فتوى المعظم بعدم كفاية الشكّ في الحكم بالطهارة.
[ ٤ ] وروى محمد بن عبد اللّه بن هلال، عن عبد الرحمان بن الحجاج، قال: قلت لأبي عبد اللّهعليهالسلام : إنّي أدخل سوق المسلمين، أعني هذا الخلق الذين يدّعون الاسلام، فأشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها: أليس هي ذكية؟ فيقول: بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنّها ذكية؟ فقال: لا ولكن لا بأس أن تبيعها، وتقول: قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنّها ذكية، قلت: ما أفسد ذلك؟ قال: « استحلال أهل العراق للميتة، وزعموا أنّ دباغ جلد الميتة ذكاته »(١) .
وهذه الرواية صريحة في الحكم بطهارة ما في أيدي مستحلّي الدباغ، وأنّه مال يصحّ بيعه وشراؤه، وأنّما المنع فيها عن البيع بشرط الطهارة الواقعيّة، التي ليس للحاكم عليه طريق غير العلم به، فلو شرط طهارته بحسب الأمارات الظاهريّة فالظاهر عدم المنع فيه.
ثمّ إن الظاهر من الصنع أن يعمل فيه عملاً يظهر فيه صفةً كصيرورته - بعد كونه جلداً - نعلاً، وأمّا دباغ الجلد، أو إعداده لصيرورته نعلاً ففي كونه صنعاً نوع خفاء وإن لم يكن بعيداً، ومثله في الخفاء طبخ اللحم، بل وذبح الحيوان، بل هما أخفى من الأوّل، كما أنّ الثالث أخفى من الثاني.
وكيف كان، فلو وجد في يد كافرٍ شيئاً يعلم أنّه من صنع بلد الاسلام: فإن علم أنّ هذه اليد طارئة فالظاهر الحكم بتذكيته، ولا ينافي ذلك قولهعليهالسلام : « إنّما عليكم أن تسألوا اذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك »(٢) لأنّ وجوب السؤال
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ ح ٤، ج ٢، ص ١٠٨١.
(٢) وسائل الشيعة: ب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين ح ٧، ج ٢، ص ١٠٧٢.
لا يقتضي إلاّ تحصيل أمارة موجبةٍ للحكم بالطهارة، فلا محالة يقيّد لغير هذه الصورة التي قامت فيها الأمارة على الطهارة.
وإن لم يعلم أنّ هذه اليد طارئة، واحتمل أن يكون ما في يده صنعه، أو صنع مثله، أو صنع مسلمٍ، فهل بمجرّد علمه بأنّه من صنع بلد الاسلام بأنّه طاهر، لأنّ صنع بلد الاسلام أمارة التذكية، وكون يده أمارة للحكم بالنجاسة، ليحصل التعارض بين الأمارتين؟ غير معلوم، بل الظاهر قولهعليهالسلام : « اذا رأيتم المشركين » أنّ ما في يد الكافر للجهل بحاله يسأل عنه، لا أنّه محكوم بالنجاسة لأمارية يده عليها، وإلاّ لكان يقول: (إنّما عليكم أن تجتنبوا عنه اذا رأيتم المشركين الى آخره) فيه إشكال، لانصراف قولهعليهالسلام : « لا بأس بالفراء اليمانيّ وما صنع في أرض الاسلام»(١) عن مثل هذه، ويحتمل منع الانصراف.
وكيف كان؛ فعلى ما ذكرنا، يمكن الحكم في السفرة المطروحة في طريق بلاد الاسلام المعلوم أنّه عمل فيها أهل بلاد الإسلام، ولكن لا يدري أنّ العامل فيه مجوسيّ أو مسلم، كما هو مفروض رواية السكوني(٢) بطهارة ما في السفرة، ولو منعنا صدق الصنع على مثل الطبخ، ويمكن الحكم عليه بالطهارة اعتماداً على تلك الرواية، وحملاً لها على هذه الصورة.
وهل يلحق بها - على هذا التقدير - ما في يد مجهول الاسلام الساكن في بلد الاسلام، أم لا؟ فيه اشكال.
ومثله في الإشكال: ما في يد مجهول الاسلام الذي لا يدري من صنع أيّ بلدٍ، إلاّ أن يكون « ذو اليد » في بلد الاسلام، ويحكم بأنّ من في بلد الاسلام محكوم عليه بالاسلام، إلاّ من علم أنّه كافر، فيكون ما في يده محكوماً بالتذكية لأجل يد المسلم المنزل كثير من أخبار السوق عليه، بل كلّها بعد تعارضها مع قولهعليهالسلام :
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين ح ٥، ج ٢، ص ١٠٧٢.
(٢) وسائل الشيعة: ب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين ح ١١، ج ٢، ص ١٠٧٣.
« اذا رأيتم المشركين »(١) .
فإن قلت: اذا كان السوق أمارة كشفٍ عن التذكية كما مر في صنع بلد الاسلام.
قلت: مفروض الرواية الشراء من السوق، الظاهر أنّه من سوق الاسلام.
فتلخّص ممّا ذكرنا: أنّ ما صنع في أرض الاسلام، وما في يد المسلم المعامل، مع ما في يده معاملة الطاهر محكوم بالتذكية، وفي حكم يد المسلم أثر استعماله سابقاً، لما عرفت من أن يد الكافر ليست بأمارة وأمّا ما وجد في طريق الاسلام، وفيه أثر الاستعمال ففيه إشكال وإن كان الحكم بتذكيته لا يخلو عن قوةٍ اذا علم أنه معمول بلد الاسلام، وأمّا يد مجهول الحال - فقد عرفت - أنّها ليست أمارة إلاّ اذا حكمنا بالحاقه بالمسلم، وكذا ما في يد كافرٍ علمنا أنّه صنع بلد الاسلام، واحتملنا كون (ذي اليد) هو الصانع.
مسألة: لو تبيّن بعد الصلاة كون ما صلّى فيه ميتةً فهل يحكم بالإجزاء أو بالإعادة؟ وجهان مبنيان: على أنّ الموت مانع مستقلّ، أو أنّه مانع لكونه موجباً للنجاسة، مع احتمال أن يفرق على الثاني بأنّ الميتة يختص بحكم، وهو المنع عن الصلاة فيما لا تتمّ الصلاة فيه منه كما دلّ عليه قولهعليهالسلام : « ولا في شسعٍ(٢) منه ».
ويمكن التمسّك على الإجزاء بإطلاق قولهعليهالسلام - فيمن صلّى في ثوب غيره أيّاماً، فأخبره صاحب الثوب أنّه لا يصلّى فيه - : « لا يعيد شيئاً من صلاته »(٣) ولكنّ في شمول لفظ الثوب لمثل الفرض منع، وأمّا ظهور عدم الفرق بين افراد النجاسات إن ثبت فهو إنّما يفيد على تقدير كون المنع للنجاسة، وفيه إشكال،
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين ح ٧، ج ٢، ص ١٠٧٢.
(٢) وسائل الشيعة: ب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة وان دبّغ ح ٢، ج ٣، ص ٢٤٩.
(٣) وسائل الشيعة: ب انه لا يجب اعلام الغير بالنجاسة ح ٤، ج ٢، ص ١٠٦٩.
والمسألة غير نقيّةٍ عن الإشكال، وإن كان القول بالإجزاء غير بعيدٍ.
ولو تبين في الأثناء كون اللباس ميتةً فحكمه كتبيّن غيرها من النجاسات في الأثناء. وقد مرّ شطر من الكلام فيه، فراجع، وتأمّل هذا.
مسألة: اذا شك في أنّ اللباس ما يصلّى فيه، أم لا مثل: إن شكّ في كونه من جلد ما يؤكل لحمه، أم لا، أو أنّه حرير محض، أم لا ففي جواز الصلاة فيه خلاف. وكذلك في المحمول، بناءاً على المنع من المعلوم منه.
فذهب المشهور كما قيل(١) الى العدم، بل لم ينقل مخالف صريح إلاّ صاحب المدارك(٢) ، وتبعه جماعة من المحقّقين كما قيل(٣) ، مثل المحقّق القميّ(٤) -رحمهالله - وذهب الى ذلك سيّد مشائخنا - قدس اللّه نفسه الزكيّة -.
حجّة القائلين بالمنع: أصالة الاشتغال، وتقريره: أنّ التكليف بالعبادة الخالية عن جنس ذلك المانع معلوم، ولا يحصل القطع (بالبراءة)(٥) الاّ بالتحرّز عن المشكوك.
وحجّة القائلين بالجواز: أصالة البراءة عقلاً ونقلاً. أمّا الأوّل فتقريره: أنّ النهي سواء كان نفسيّاً أو غيريّاً يرجع الى تكاليف متعدّدة.
فمرجع النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه الى النهي عن كلّ فردٍ من أفراده بالعموم الاستغراقي الافرادي، فيكون مرجع الشكّ، فيصدق عنوان ما لا يؤكل لحمه على شيء إلى كونه مستقلاً نهي عن الصلاة فيه كسائر أفراد ما لا يؤكل لحمه التي نهي عن كلّ واحدٍ منها بالخصوص لأجل صدق العنوان عليه، فيكون نظير الشكّ
____________________
(١) المنتهى: في لباس المصلّي ج ١، ص ٢٣١.
(٢) المدارك: في لباس المصلّي ج ٣، ص ١٦٧ س ٦.
(٣) الحدائق: الصلاة في الثوب المنسوج من ما يؤكل وما لا يؤكل ج ٧، ص ٨٦.
(٤) لم نعثر عليه.
(٥) أضفناها من (ط ٢).
في صدق عنوان الحرام كالخمر على شيءٍ فكما أنّ الأصل براءة الذمّة فيه كذلك فيما نحن فيه.
والحاصل: أنّا لا نعقل الفرق بين النهي الغيريّ والنفسيّ بحسب الشمول اللفظي، وبحسب الانطباق على الأفراد، فكلّ فرد شكّ في صدق الماهيّة عليه يكون الشكّ فيه راجعاً الى الشك في التكليف، والاصل فيه البراءة.
فإن قلت: إنّا لا نفرّق بين أفراد النهي بحسب الشمول والانطباق.
بل نقول: إنّ إجزاء أصالة البراءة في النهي الغيريّ لا محصّل له، وذلك لأنّ النهي الغيريّ بما هو نهي غيريّ لا تترتّب على مخالفته مؤاخذة يحتاج إثبات تلك المؤاخذة الى البيان، (حتى ينفى)(١) تلك عند عدم البيان بقاعدة قبح المؤاخذة قبل البيان، بل لأداء مخالفته الى مخالفة الأمر النفسيّ، وقد تمّ البيان بالنسبة اليه.
والحاصل: أنّ الشكّ في التكليف الغيريّ ما لم يكن مرجعه الى الشكّ في التكليف بالنسبة الى النفسيّ لا معنى لإجراء أصالة البراءة فيه.
والأمر - هنا - معلوم تفصيلاً، وهو الأمر بالصلاة الخالية عن الموانع التي علمت هي بذواتها، والشكّ في صدقها على شيءٍ راجع الى الشك في امتثال ذلك التكليف المعلوم تفصيلاً.
قلت: إنّ الأمر النفسيّ المذكور يرجع بعد التحليل الى أمرٍ بأفعال معلومةٍ بالذات، وتروكٍ معلومةٍ بالعنوان، مجهولة الاشخاص.
فكلّ ترك علم أنّ عنوان المنهيّ عنه صادق عليه يكون داخلاً في المأمور به، وكل ترك شكّ في صدق العنوان عليه شكّ في دخوله فيه.
وقد قرّر في مسألة الاحتياط والبراءة أنّ الشكّ في دخول شيء في المأمور به لرجوعه الى تيقّن مطلوبية الأقل، والشك في الزائد يرفع حكمه بأصالة البراءة عن الزائد المشكوك فيه.
____________________
(١) اضفناها من (ط ٢): وفي (ط ١): « وينتفي » وهو تصحيف.
فإن قلت: العلم بعنوان المأمور به كافٍ في ثبوت الاشتغال، والشبهة المصداقيّة مرجعها الى الشبهة في حصول العنوان الذي علم اشتغال الذمة به.
قلت: الاشتغال المعلوم الحصول هو اشتغال الذمّة بالأجزاء، وتروك المعلوم صدق العنوان عليها، وأمّا غيرها فاشتغال الذمّة به غير معلوم.
وتوضيح هذا المرام: أنّ المنع عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه يرجع الى النهي عن إيقاع الصلاة في تحصّلات تلك الماهيّة، كما أنّ النهي عن شرب الخمر يرجع الى النهي عن شرب تحصّلات تلك الماهيّة في الخارج، وحينئذٍ فلا يكون العلم بالعنوان بياناً.
وتوضيحه: أنّ الطلب المتعلّق بالماهيّة اذا كان على وجه السراية، ولم يكن بدليّاً، سواء كان وجوبيّاً مثل قولنا: تواضع للعالم، أو تحريمياً مثل قولنا: لا تشرب الخمر، نفسيّين كالمثالين، أو غيريّين كما لو أمر بالصلاة، وأمر بقراءة تمام القرآن فيه على وجه الجزئية، ثم شككنا في أنّ المعوّذتين من القرآن أم لا، أو نهي عن التكلم بكل كلام أومأ فيه، سواء كان ذلك النهي بملاحظة دخل التروك المنتزعة من النهي في الماهيّة شطراً أو شرطاً، أو بملاحظة مانعيّة الوجودات لها لا تكون الماهية الملحوظة في ذلك الطلب - حينئذٍ - في نظر العقلاء، إلاّ كالمعرّف الأجنبيّ، الذي لوحظ به المطلوب.
غاية الأمر: أنّ العرف لا يكون علّةً للحكم ومنشأ به بخلاف مثل هذه الماهيّة، فأنّ صدقها على الأفراد علّة لمحبوبيّتها، أو مبغوضيتها (ويكون الشك في صدقها راجعاً الى الشك في أصل الطلب)(١) .
والسرّ في ذلك كلّه حقيقة أنّ العلم بالكبرى، مع قطع النظر عن انضمام الصغرى لا تترتّب عليه النتيجة، والعلم بالنتيجة في ضمن الكبرى علماً إجمالياً لا يعدّ بياناً للنتيجة.
____________________
(١) أضفناها من (ط ٢).
ولأجل ذلك، لم يتأمّل أحد في الشبهات الموضوعيّة (في التكليف النفسي)(١) في كلا قسميه، الوجوبي والتحريمي في أنّ الأصل فيه البراءة عقلاً ونقلاً.
وملخّص الكلام: أنّ العقل بعد ملاحظة الأمر الغيريّ الساري مثل قوله (اقرأ القرآن في الصلاة) أو النهي الغيري مثل قوله: « اجتنب عمّا لا يؤكل لحمه في الصلاة » ينتزع أجزاءً معلومةً: وهي ما علم صدق القرآن عليه، وموانع معلومة: وهي ما علم أنّه مما لا يؤكل لحمه، وأجزاء مشكوك الجزئية، وموانع مشكوكة كذلك.
غاية الامر: أنّ علّة جزئيّة تلك الأجزاء، أو مانعية الموانع هي صدق الماهيّة عليها، وإلاّ فحقيقة الجزء والمانع هي ذوات تلك الأشخاص.
وحينئذٍ، فمن بنى على البراءة في الشك في الجزئيّة والمانعيّة لا محيص له - هنا - عن إجراء البراءة.
فان قلت: فرق بين ما نحن فيه، ومسألة البراءة في الشكّ في الشرطيّة والجزئية، لأنّ الشكّ هناك في جعل الشارع، والشكّ هنا في الأمر الخارجيّ.
قلنا: اذا رجع الشكّ في الأمر الخارجي الى الشكّ في الجعل فأيّ محصّلٍ في هذا الفرق؟ وهلاّ فصلت بين الشبهات الحكميّة التحريميّة، أو الوجوبيّة، وبين الشبهات الموضوعيّة
فإن قلت: الأمر في المانع لم يرتبط بالماهيّة السارية، بل مرتبط بحقيقة الجنس، ولازمه ترك جميع الأفراد، وذلك نظير ما نذكر في باب تداخل الاسباب: أنّ الجنس قد يكون سبباً - وحينئذٍ - لا يتكرّر بتكرّر الأفراد، ولا يتكسّر بتكسّرها.
نعم، لمّا كان عدم الجنس بهذا المعنى غير منفكّ عن عدم جميع الأفراد لزم تركها من باب الملازمة والمحصّليّة.
____________________
(١) اضيفت لضرورتها من (ط ٢).
والحاصل: أنّ النهي بهذه الحيثيّة ليس نهياً عن الأفراد، ولا يكون المانع بهذا المعنى هي الافراد، كما أنّ السبب اذا لوحظ الماهيّة بهذه الحيثيّة ليس هو الافراد، فلا يكون لزوم ترك الأفراد من اقتضاء الأمر النفسيّ، بل لملازمته لما يقتضي لزومه.
وحينئذٍ، يكون الشكّ في فردية شيءٍ شكاً في حصول عنوان المأمور به، الذي علم الاشتغال به.
قلت: أولاً: لا نسلّم أنّ المانع هو الجنس، بل الظاهر من الأوامر والنواهي العرفيّة المتعلّقة بالأسباب، والموانع سببيّة الأفراد، ومانعيتها من حيث انطباق الجنس عليها، ولأجل ذلك ذكرنا هناك: أنّ عدم تداخل الأسباب من مقتضيات الاصول اللفظيّة.
وثانياً: لا محصّل لهذا الكلام، لأنّ الماهيّة بهذه الحيثيّة عبارة اخرى عن مجموع ما وجد في الخارج من الأفراد، فمرجع الشكّ في المانعيّة الى الشك في أن المانع مجموع امور، يكون المشكوك جزءً منها، أو مجموع امور ليس هذا منها، فمرجع الشك الى دخل شيءٍ زائدٍ عن المقدار المعلوم في الأمر النفسيّ.
فإن قلت: مجموع الأفراد ملازم للجنس في الخارج.
قلت: إنّا نلغي جميع الخصوصيات المنضمة الى الأفراد، ونلاحظ نفسالجهة التي تشتمل على الفرد، وهي جهة المانعيّة والموجود الخارجي، فيكون مرجع النهي الى اجتناب مجموع تلك الحصص الموجودة من حيث كونها نفس الماهية، لا من حيث كونها اموراً متباينةً متكثّرة، وهي بهذه الملاحظة، يكون النهي عن الماهيّة عبارة اخرى عن النهي عنها.
هذا خلاصة ما أفاده سيد مشائخنا - في مدرسته المباركة، حين تشرفنا بخدمته في داره المباركة، المعروفة (بسرّمن رأى) شكر اللّه سعيه، وأجزل عن الاسلام وأهله مثوبته، ووفقنا وسائر تلامذته للمشي على منواله، والسلوك على مسلكه، « ولا حول ولا قوة الاّ باللّه العلي العظيم ».
وأمّا البراءة النقليّة: فعمدة ما تمسّك به المستدلّ قولهعليهالسلام : « كلّ شيءٍ فيه حلال وحرام فهو لك حلال »(١) .
وتقريبه: أنّ الحلّ والحرمة كما يطلقان على الحرمة والحلّ النفسيين، كذلك يطلقان على الحلّ والحرمة الغيرييّن.
وقد شاع استعماله في هذا المعنى في الأخبار مثل: قول الصادقعليهالسلام في رواية عبد اللّه بن سنان:« كلّما كان عليك، أو معك(٢) ممّا لا يجوز الصلاة فيه منفرداً »(٣) .
وفي رواية موسى بن أكيل(٤) ، وفي (غير)(٥) ذلك: « لا تجوز الصلاة في شيء من الحديث »(٦) .
وقول أبي محمدعليهالسلام في رواية ابراهيم بن محمد الهمدانيّ: « لا تجوز الصلاة فيه »(٧) .
وقولهعليهالسلام في صحيحة عبد الجبار: « لا تحل الصلاة في الحرير المحض »(٨) .
وقولهعليهالسلام في صحيحة عبد الجبار الاخرى: « لا تحلّ الصلاة في حريرٍ محضٍ »(٩) .
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب عدم جواز الاتفاق من الكسب الحرام ح ١، ج ١٢، ص ٥٩.
(٢) في « ط ٢ »: « أو معك ظ ».
(٣) تهذيب الاحكام: ب ١ تطهير الثياب ح ٩٧، ج ١، ص ٢٧٥.
(٤) في « ط ٢ »: « موسى بن الكميل ظ ».
(٥) اضيفت من « ط ٢ ».
(٦) وسائل الشيعة: ب عدم جواز لبس الرجل الذهب ح ٥، ج ٣، ص ٣٠٠.
(٧) وسائل الشيعة: ب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه ح ١ ، ج ٣، ص ٢٧٧.
(٨) وسائل الشيعة: ب حكم ما لا تتم الصلاة منفرداً اذا كان حرير ح ١، ج ٣، ص ٢٧٣.
(٩) وسائل الشيعة: ب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض ح ٢، ج ٣، ص ٢٦٧.
و قول أبي محمدعليهالسلام - ظاهراً - في صحيحة عليّ بن مهزيار : « هل تجوز الصلاة في وبر الأرانب (الى أن قال) : فكتب : « لا تجوز الصلاة »(١) .
وقول أبي عبد اللّهعليهالسلام في رواية الحلبيّ(٢) كذلك: « ما لا يجوز الصلاة فيه وحده »(٣) الى غير ذلك من الموارد التي يطول بذكرها الكتاب.
والحاصل: أن الحلّ والحرمة في لسان الأئمةعليهمالسلام ظاهر في الأعمّ من الحرمة الغيريّة والنفسيّة، بل الحرمة العرضيّة.
وحينئذٍ نقول: مقتضى ظاهر الحديث جواز الصلاة في المشكوك، فأنّه شيء لا تعلم حلية الصلاة فيه.
وقد قالعليهالسلام : « كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال »(٤) وللجلود والاصواف قسم تحلّ الصلاة فيه، وقسم لا تحلّ الصلاة فيه، فيحكم في المشكوك بالحلّ، كما هو ظاهر الحديث.
فإن قلت: استعمال اللفظ في المعنى (مع القرينة)(٥) لا يوجب الاستناد اليه مع عدم القرينة.
قلت: نعم، إن لم يستكشف منه أنّ عادة المستعمل إفادة المعنى من نفس اللفظ، وذلك نظير ما في أخبار(٦) السلام « السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين انصراف، أم لا »، فأنّه ظاهر في أنّ الانصراف عند المستعمل كان معناه هو الخروج عن الصلاة.
وبالجملة: المتتّبع في الأخبار يظهر له أنّ الحلّ والحرمة أعمّ من المعنى الذي
____________________
(١) في « ط ٢ » هكذا « كلّ ما لا يجوز الصلاة فيه وحدها » فراجع النسخة المخطوطة (ب) ص ٣٧.
(٢) وسائل الشيعة: ب حكم ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً اذا كان حريراً ح ٣، ج ٣، ص ٢٧٣.
(٣) وسائل الشيعة: ب حكم ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً اذا كان حريراً ح ٢، ج ٣، ص ٢٧٣.
(٤) وسائل الشيعة: ب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام ح ١، ج ١٢، ص ٥٩.
(٥) أضفناها من « ط ٢ ».
(٦) وسائل الشيعة: ب كيفية التسليم وجملة من احكامه ح ١ و ٢ و ٥ ، ج ٤، ص ١٠١٢ و ١٠١٣.
ينصرف اليه اللفظ في أمثال زماننا.
ولكنّ الانصاف: أنّ دعوى الظهور لا يخلو من إشكال.
ويمكن توجيه الاستدلال بوجهٍ آخر، وهو: أنّ ليس ما لا يؤكل لحمه في (حال)(١) الصلاة محرّم غيريّ حقيقةً، وليس حرمته مثل حرمة الصلاة عرضيّاً فيشمله اللفظ من هذه الحيثيّة.
فنقول: في الجلد أنّ منه ما يجوز لبسه في حال الصلاة، ومنه ما لا يجوز لبسه في حالها، فيجوز لبس المشكوك.
قلت: إن استفيد من الحكم بالحلّ - في الحديث - حيثيّة رفع المانعيّة كان الاستدلال موجّهاً، ولكنه لا يخلو عن إشكال.
تنبيه: اذا شكّ في حيوان أنّه محلّل أكله في أصل الشرع، أم لا، بعد فرض قبوله التذكية فلا إشكال في أنّ أصالة البراءة(٢) تثبت، حلّ أكله.
وهل تجوز الصلاة في وبره وجلده، لأنّه جلد حيوان يحل أكله بالأصل، أم لا؟ فيه إشكال، من حيث أنّ الظاهر من النواهي الواردة هو النهي عن الذي لا يحلّ أكله واقعاً.
وبعبارة اخرى: ورد على الموضوعات الواقعية حكمان: أحدهما: حرمة الأكل، والآخر: حرمة الصلاة في أجزائها، ونفي أحد الحكمين في الظاهر لا يلازم نفي الآخر.
ويمكن أن يقال: مناط المنع حرمة الأكل المفقودة - هنا - بحكم الأصل، وفيه منع.
أو يقال: إنّ المتشرّعة اذا حكم لهم بحلّيّة أكل حيوان لا يشكّون في أنّ الصلاة فيه جائز.
ومن ذلك يظهر الكلام في الحيوان الذي حكم عليه في الشبهة الموضوعيّة
____________________
(١) أضفناها من « ط ٢ ».
(٢) في « ط ٢ » استعمل لفظ « الحلّ » بدل « البراءة » هنا، فلاحظ.
الخارجيّة بحلّ الأكل. والمسألة محلّ تأمّلٍ وإشكال، وإن كان القول بالجواز قويّاً.
وأمّا الصوف والوبر من الحيوان الذي فقد، ولا يعلم أنّه من أيّ صنفٍ فأصالة الحلّ فيه تقديريّة، ضرورة أنّ الحكم الظاهريّ تابع للموضوع الفعليّ المشكوك بالفعل، فلا أثر لأصالة الحلّ فيه من هذه الجهة.
نعم، أصالة البراءة والحلّ تجريان هنا، كما حكيناه مفصّلاً عن سيّد مشائخنا. ولكنّ نفسي بعد لم تطمئن بالحكم كما ينبغي الركون اليه - أزاح اللّه عللنا بفرج آل محمدٍ صلى اللّه عليهم أجمعين -.
ثمّ إنّه قد يتمسّك لجواز(١) الصلاة في المشكوك بالاستصحاب، وتقريره من وجوه:
الأوّل: أصالة عدم كون المصلّي لابساً لغير المأكول، أو مصاحباً له، وهو مبنيّ على أن يكون الشرط هو عدم لبس المصلي، لا عدم كون الصلاة واقعةً في غير المأكول، كما هو ظاهر النواهي الواردة في الباب.
الثاني: أصالة عدم وقوع الصلاة في غير المأكول، لأنّ المعنى المستفاد اعتباره في الصلاة هو عدم وقوعها في ما لا يؤكل لحمه، والأصل عدمه.
وفيه: أنّ أصالة عدم وقوع كلّيّ الصلاة في غير ما لا يؤكل لا يثبت سلب الوقوع في غير ما يؤكل للجزئيّ الذي فعله المكلّف، والمستفاد من الأدلّة سلب وقوع الجزئيّ، الذي تلبّس به المكلّف في غير ما يؤكل.
فإن قلت: إنّ الأصل عدم وقوع هذا الجزئيّ في ما لا يؤكل، ضرورة أنّ وقوعها فيه أمر مسبوق بالعدم فالاصل بقاء العدم السابق.
قلت: المستفاد من الأدلّة شرطية السلب بعناية وجود الموضوع، لا السلب الأعمّ من سلب الموضوع، وسلب المحمول.
____________________
(١) في (ط ١): « بجواز » والأظهر ما أثبتناه كما في (ط ٢).
ولا ريب أنّ السلب بتلك العناية ليس (لها حالة)(١) بعنايةٍ سابقة (فتستصحب)(٢) ، فافهم. فإنّه لا يخلو من دقّةٍ.
ثم إنّه قد يدّعى أنّ المستفاد من أخبار منع الصلاة عمّا يؤكل لحمه اعتبار العلم بكون الجلد ممّا يؤكل لحمه اذا أراد الصلاة فيه مثل: قولهعليهالسلام في موثقة ابن بكير: « يا زرارة، فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره، وشعره، وروثه، وألبانه، وكلّ شيء منه جائز، اذا علمت أنّه ذكي قد ذكّاه الذبح، وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله وحرّم أكله فالصلاة في كلّ شيءٍ منه فاسد، ذكّاه الذبح، أو لم يذكّه،(٣) بناءاً على أنّ المراد من الذكي في قولهعليهالسلام : « اذا علمت أنّه ذكي » كونه ممّا يؤكل لحمه، وفيه نظر؛ لأنّ الظاهر من الذكي أنّه في مقابل النجس، كما ورد: « كلّ يابسٍ ذكي »(٤) .
مسألة: إن زاد في الصلاة ركعةً عمداً بطلت بلا إشكال ولا خلاف، وإن زاد سهواً: فإن كان قبل الجلوس بمقدار التشهّد بطلت أيضاً، بلا إشكال ولا خلاف، وإن كان بعد الجلوس مقدار التشهّد فقد يقال بالصحة، لأنّ ذلك من نسيان التشهّد والسلام، وربّما يفصل بين الوقوع بعد التشهّد وقبله، فيحكم بالصحة في الأوّل وتجعل الرواية من أدلّة استحباب التسليم.
ويمكن حمل تلك الأخبار على فعل التشهّد الطويل، الذي رواه أبو بصير، المشتمل على (السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين)(٥) فتكون الصحة لأجل عدم وقوع الزيادة على الصلاة.
لا يقال: الزيادة على الصلاة ليس معناها وقوعها في أثنائها، بل هو نظير
____________________
(١) و (٢) أضفناهما من « ط ٢ ».
(٣) وسائل الشيعة: ب جواز الصلاة في الفراء والجلود و. اذا كان مما يؤكل لحمه ح ١، ج ٣، ص ٢٥٠.
(٤) وسائل الشيعة: ب وجوب الاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول ح ٥، ج ١، ص ٢٤٨.
(٥) وسائل الشيعة: ب كيفية التشهد وجملة من احكامه ح ٢، ج ٤، ص ٩٨٩ و ٩٩٠.
الزيادة في الطواف، المتحقّقة بلحوق جزءٍ من سنخه به، فتكون الركعة المتّصلة بها - عرفاً - زيادةً فيها.
لا نقول: إن السلام حائل شرعاً بين الصلاة ولحوق شيءٍ بها، وهذا معنى كون تحليلها (السلام).
ومن هنا ظهر: أنّه لا يصحّ القول بالصحة بناءً على أنّ السلام غير واجبٍ اذا وقعت الزيادة قبل الإتيان بالسلام الواجب، لانه لا مانع من لحوق شيء بالصلاة.
ودعوى أنّ ذلك من نسيان التسليم، كما أنّه اذا وقعت الزيادة قبل فعل التشهّد يكون من نسيان التشهّد والتسليم معاً، فاذا فصل الجلوس بمقدار التشهّد بين الركعة الزائدة، وبين الصلاة لم تتصل الزيادة بالصلاة، وكان فساد الصلاة من باب نسيان الأجزاء الغير الركنيّة، التي لا نلزم بكونها مفسدةً اذا تركت عن سهوٍ.
يدفعها: أنّ فصل مقدار التشهّد من الجلوس، وكذلك نفس التشهّد لا يمنعان عن صدق الزيادة، لأنّ الركعة الثالثة تتّصل(١) بالركعة الثانية مع فصل التشهد بينهما.
والحاصل: أنّ مدّعي الصحة يزعم أنّه مع الفصل بمقدار الجلوس لا تتّصل الزيادة بالصلاة عرفاً.
فإن قلنا: إنّ محلّ التشهّد باقٍ لزم لحوقها، وحيث أنّه يلزم من إيجاب التشهّد فساد الصلاة بلحوق الزيادة بها وجب الحكم بسقوط التشهّد، كما هو الشأن في كلّ جزء ترك نسياناً الى أن يذكر في محلّ لو بني على وجوبه لزم فساد الصلاة من جهة وجود المانع.
وجوابه: أنّ الزيادة حاصلة بنفسها.
وبالجملة: قد يكون حاصلاً بنفسه، وقد يكون حصوله ناشئاً من إرادة الجزء المنسيّ، فإن كان منشؤه إرادة الجزء المنسيّ سقط الجزء، كما هو الشأن في كلّ
____________________
(١) في (خ أ) : « متّصل » وهو تصحيف، ولما أثبتناه كما في (خ ب).
جزءٍ لو اريد تداركه في محلّه لزم منه تكرار الركن الموجب لفساد الصلاة، وكون الواقع - سابقاً - زائداً ، وحيث أنّ الفصل بالجلوس بمقدار التشهّد لا يمنع عن اتّصال الزيادة بالصلاة، بحيث لو قلنا: بأن التشهّد، أو التسليم ليسا بواجبين لقلنا بوقوع الزيادة في الصلاة، لم يكن البطلان مستند الى اعتبار التشهّد والتسليم في الصلاة، حتى يقال: إنّ نسيانهما لا يفسد الصلاة.
ومن هنا ظهر: أنّه يمكن القول بصحة صلاة من أحدث قبل التشهّد والتسليم، أو استدبر القبلة، زاعماً أنّه فعلهما، لأنّ كون الحدث في أثناء الصلاة، وكذلك الاستدبار إنّما هو ناشيء من جزئيّة التشهّد والتسليم، وكلّ جزءٍ ترك ولزم من إرادته وقوع المفسدة في الصلاة سقط بالنسيان المؤدّي الى ذلك بخلاف ما نحن فيه. وإن أمكن المناقشة فيه بأنّ لازم ذلك الحكم بصحة صلاة من أحدث، أو استدبر بعد السجدتين الأخيرتين مطلقاً إن كان ناسياً كونه في الصلاة، سواء اعتقد أنّه تشهّد وسلّم، أو لم يعتقد، إذ لم يكن التشهّد والتسليم جزئين للصلاة لم يكن الحدث واقعاً في الصلاة، فيلزمه أن يسقط الجزئية بسبب هذا النسيان، إلاّ أن يدّعى أنّه لا يصدق عرفاً في هذا الفرض إن ترك التشهد والتسليم نسياناً، بل يعدّ ذلك من فعل الحدث نسياناً.
فإن قلت: فرق بين التشهّد في الركعتين الأوّلتين من الرباعيّة، والتشهد الأخير من الصلاة، وهو أنّ هذا المقدار لا يمنع من لحوق الجزء، وأمّا الزيادة فيمنعها.
قلت: إن كان هذا الفرق شرعيّاً، كما ادّعيناه في السلام فيحتاج الى دليلٍ وافٍ به، وإن كان عرفيّاً فهو ممنوع أشدّ المنع، فالحكم بالصحة في هذه المسألة بحسب القواعد بعد تسليم أنّ الزيادة مبطلة مشكل جداً.
نعم، يمكن التمسّك بالروايات الصحيحة، الفارقة في الصحة والفساد بين فصل مقدار الجلوس من التشهّد، وغيره (ويلتزم)(١) بأنّ مثل هذه الزيادة لا تفسد، ويلزم
____________________
(١) أضفناها من « ط ٢ ».
بأنّه يبقى محلّ التشهد والتسليم، فإن تذكّر قبل فعلهما فعلهما، وإن تذكّر بعدهما فقد أتى بالواجب عليه.
و الجواب عن التمسك بتلك الأخبار - حينئذٍ - منحصر في أنّها مهجورة، لم تعمل بها الطائفة، فإن ثبت الهجر(١) فهو، و إلاّ وجب تخصيص مطلقات الزيادة، وكأنّ العاملين بهذه الأخبار لا يلتزمون بأنّ الزيادة حاصلة، وأنّها غير مفسدةٍ، وإنّما غرضهم توجيه المسألة على وجهٍ لا يلزم منه وقوع الزيادة في الصلاة، فهم في الحقيقة غير مخالفين للمشهور، وغير آخذين بالروايات من باب التعبّد بها، فلو كان عملهم بها جابراً لم يف لجبره إلاّ أن يمنع ذلك.
ويقال: إنّ سندهم في المسألة أمران: أحدهما القاعدة، والآخر الرواية، فتأمّل.
مسألة: لو نسي سجدتين، ولم يدر أنّهما من ركعةٍ واحدةٍ، أو من ركعتين، وكان ذلك العلم في محلّ يتعيّن عليه أحد الأمرين: الإعادة، أو قضاء السجدتين، أو أحد ثلاث: إعادة السجدة، أو القضاء، أو إعادة الصلاة، كما لو قام الى الرابعة، وعلم أنّه ترك السجدتين، ولم يعلم أنّ شيئاً من المتروك من الركعة التي قام عنها، فإن كان مفروض المسألة بعد الصلاة ففي وجوب الإعادة أو قضاء السجدتين أو الاحتياط بالجمع بينهما، أو البناء على صحة الصلاة بلا قضاءٍ وجوه: صريح الشرائع(٢) ، وجمع(٣) ، وظاهر المشهور، كما قيل(٤) : هو الأوّل وعن بعض متأخّري(٥)
____________________
(١) في « ط ١ »: « الهجرة » وهو تصحيف، والظاهر ما أثبتناه كما في « ط ٢ ».
(٢) شرائع الاسلام: فيما لو احلّ بركن ج ١، ص ١١٥.
(٣) التحرير: في الخلل الواقع في الصلاة ج ١، ص ٤٩، س ١٥، والبيان: في الخلل الواقع في الصلاة ص ١٤٥، س ١٧.
(٤) كفاية الاحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ص ٢٥، س ١٠.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان: في مبطلات الصلاة ج ٣، ص ٩٤، ومدارك الاحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج ١، ص ٢٣٠.
المتأخرين البناء على الصحة من غير تعرض لحكم القضاء، ولعلّ الأقوى هو الأوّل، لاستصحاب بقاء تكليفه بالصلاة، ولأنّه شاكّ في حصول البراءة بعد اليقين باشتغال ذمّته بالصلاة فيجب احتياطاً، ولاستصحاب البراءة عن القضاء، وأصالة البراءة عن ذلك، مع الشك في حدوث شغل الذمّة، والعلم الاجمالي بوجوب أحد أمرين: إنّما يوجب الاحتياط بالجمع اذا لم يتعيّن احد طرفيه للاحتياط. والآخر للبراءة بحسب التكليف المعلوم بملاحظة الاصول الجارية في المورد، بملاحظة ذلك التكليف، كما برهن ذلك في الاصول.
لا يقال: اذا بنى على ذلك وجب الحكم بصحة الصلاة، وقضاء السجدتين لفوات السجدتين بالوجدان، وأصالة عدم حصول الجمع الموجب للبطلان.
لأنّا نقول: لا نسلّم أنّ القضاء سببه فوات السجدتين، بل الموجب له الفوات بشرط التفريق، وهو غير معلومٍ.
كما أنّ فواتهما - مجتمعين - الموجب للبطلان غير معلومٍ.
وملخّص الكلام: أنّ أصالة عدم القاطع، وقاعدة الشكّ بعد الفراغ من حيث تعلّقها بنفي القاطع لا يحرز أن تحقّق السجدتين اللتين كلّف بإتيانهما في المحلّ، أو بعد الصلاة قضاءاً، والشكّ بعد الفراغ بالنسبة الى الأمرين على حدٍ سواء، وعدم وجوب الإعادة من حيث عدم حدوث البطلان غير وجوبها من حيث استلزام تكليف الإتيان بالسجدتين في المحّل لها، فدوران الأمر بين الإعادة والقضاء من هذه الحيثيّة لا تؤثّر فيه أصالة عدم القاطع وإن كان مفروض المسألة في الأثناء.
فقد يقال بوجوب الإتمام، ثم الإعادة، أو الإعادة(١) ، أو الاحتياط بالجمع بينها وبين القضاء، لأنّ الاصول النافية لترك الركن لا معارض لها، لأنّ التكليف بالقضاء مشروط بالإتمام، فيحرم عليه ظاهراً فعل ما يكون مبطلاً.
____________________
(١) أي: (أو وجوب الإعادة). ففي « ط ١ » « أو للإعادة » ولم توجد في « ط ٢ » والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الأرجح.
ويمكن المناقشة فيه بمنع حرمة إبطال ما يعلم أنّه لا يحصل القطع بفراغ الذمّة به، لا واقعاً ولا ظاهراً، بل لا معنى للبطلان إلاّ ذلك، فتأمّل.
ولكن يمكن أن يقال: استصحاب الأمر بالصلاة لا يثبت كون التكليف هو الاستئناف إلاّ بالملازمة العقلية، وأصالة الاشتغال وحدها لا تكفي في رفع أثر العلم الإجمالي، وحينئذٍ فالعلم الإجمالي بوجوب الاستئناف، أو السجدة قضاءً لا رافع لأثره.
فالقول بوجوب الاحتياط بالجمع بين السجدة قضاءً والإعادة - كما هو الظاهر - من نجاة العباد(١) ، وتقرير شيخنا(٢) وسيّد مشائخنا - قدّس اللّه أسرارهم - لا يخلو عن قوّة. ولكنّ المسألة بعد محتاجة الى التأمّل.
ولو بنى على وجوب الإعادة، وعدم وجوب الإتمام، واستأنف الصلاة، ثمّ تجدّد رأيه بعد الصلاة، فإن قلنا: إنّ الصلاة الاولى بطلت بحصول الماحي فلا إشكال، وكذلك إن لم نقل بذلك، لأنّ ذمّته عن الصلاة التي امر بها فرغت بالإتيان بالفرد الثاني، فلا موجب لوجوب إتمام الأوّل.
الاّ أن يقال: يحتمل أن تكون الصلاة الاولى صحيحة، ومع فرض صحّتها لا يكون إتيان الأجزاء المأتي بها أوّلاً عبادةً لحصول الاجزاء، وعود الأمر فرع البطلان المتفرّع على حصول الماحي، أو المبطل الآخر وفيه منع حقّقناه في الاصول.
أو يقال: التكبير الثاني على تقدير حصول البطلان به لا تنعقد به الصلاة، وفيه أيضاً منع، فتأمّل.
ولو تجدّد رأيه في الأثناء فهل يتخيّر في إتمام ما اشتغل فيه أوّلاً، أو الثاني، أو يتعيّن الأوّل، أو الثاني أو يجب الإعادة من رأس؟ وجوه، ومبنى الإشكال: أنّ
____________________
(١) نجاة العباد: ص ١٥٠، المقصد الخامس.
(٢) كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري) : ص ٢٢٤ - ٢٢٥.
استئناف التكبير بعنوان صلاة اخرى في أثناء الصلاة مبطل للاولى أم لا؟ وعلى الأوّل فهل تنعقد به الصلاة أم لا؟ ولعلّ الأقوى هو ثالث الوجوه، وسيأتي لذلك مزيد توضيحٍ في بعض فروع الشكوك المبطلة.
مسألة: لو هوى الى السجود ناسياً للركوع، فإن تذكّر بعد حصول مسمّى السجدة فالمشهور(١) البطلان، للنصوص(٢) الدالّة على أنّ من ترك الركوع حتى سجد يعيد، ولأنّ الأمر دائر بين زيادة الركن، الذي هو مسمّى السجدة في كلّ ركعةٍ، أو نقصانه، وفي كلا الوجهين إشكال، لأنّ ما دلّ منها على البطلان دلالته بالاطلاق، وأسانيدها لا تخلو عن شيء.
وفي رواية أبي بصير دلالة على الصحة من حيث ترك الركوع اذا لم يكن التذكّر بعد فعل السجدتين، قال: قال أبو عبد اللّهعليهالسلام : » اذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعةً من الصلاة، وقد سجد سجدتين، وترك الركوع استأنف الصلاة »(٣) .
إلاّ أن يقال: إن مفهومها نفي الإعادة، لعدم اليقين بوقوع الترك، فتأمّل. وأمّا ما ذكر من زيادة الركن ففيه منع.
ودعوى أنّ المسمّى ركن، والزائد عليه غير ركنٍ يدفعه حصول البطلان بزيادة سجدتين ولو كان في ركعة واحدة.
وكيف كان، فالإتيان بالركوع قائماً، وإتمام الصلاة، ثمّ الإعادة أحوط، ولو تذكّر ولمّا يسجد فإن تذكّر قبل وصوله الى حدّ الركوع الشرعيّ فالظاهر جواز إتمام الهوي ركوعاً، لأنّ القيام قبله حاصل، والهوي مقدّمة لا يعتبر فيه قصد كونه للركوع.
إلاّ أن يقال: إنّ الركوع هو نفس الانحناء من القيام الى الحدّ الشرعيّ، وفيه منع لا يخفى وجهه.
____________________
(١) نهاية الاحكام: في السهو عن الركن ج ١، ص ٥٢٨، والبيان: في الخلل الواقع في الصلاة ص ١٤٥. س ٨، وجامع المقاصد: في احكام السهو ج ٢، ص ٤٨٨.
(٢) وسائل الشيعة: ب بطلان الصلاة بترك الركوع عمداً كان أو سهواً ح ١ و ٢ و ٣ و ٤ ج ٤، ص ٩٣٣.
(٣) وسائل الشيعة: ب بطلان الصلاة بترك الركوع عمداً وسهواً ح ٣، ج ٤، ص ٩٣٣.
أو يقال: إنّه يعتبر في الركوع اتصاله بالقيام، والهوي الذي يغتفر فصله ما وقع بعنوان المقدّميّة للركوع، وفيه أيضاً منع.
ولو تذكّر، وقد وصل الى حدّ الركوع ففي جواز احتساب بقائه ركوعاً إشكال، منشؤه: أنّ الركوع إحداث هيئة الانحناء، أو ما يعمّه، والبقاء.
كل ذلك اذا لم يتخلّل بين تذكّره والوصول الى حدّ الركوع وقوفاً يعدّ - عرفاً - فاصلاً بين القيام والركوع، زائداً على الهوي الذي لابدّ من فصله، وأمّا معه فلا إشكال في وجوب العود الى القيام والركوع حاله.
وهل يجوز له زيادة الانحناء في ما اذا لم يقع غير الهوي فاصلاً، وجعل ذلك الانحناء الزائد ركوعاً؟ فيه إشكال: من أنّ المسمّي حاصل، والزيادة ليست إحداثاً له، ومن أنّه كان له في أوّل الأمر نيّة الركوع بهذا الانحناء، وجعل ما يحصل به مسمّى الركوع كسابقه من مراتب الهوي مقدّمةً فلا يبقى فرق بين القصد من الابتداء، وما نحن فيه، إلاّ في نيّة المقدّميّة، وعدمها، وظاهر أنّ ذلك لا دخل له في صحة الركوع.
وتوهّم كونه فاصلاً بين القيام والركوع مدفوع بما مرّت الاشارة اليه، والمسألة محتاجة الى التأمّل. ولو وصل الى حدّ الركوع واستقر، ثمّ ذهل وهوى الى السجود فالظاهر صحة العمل إن كان بعد الدخول في السجود، وفي وجوب العود لإدراك القيام بعد الركوع إشكال، منشؤه النصّ، واحتمال الدخول في الركن، وقد أشبعنا الكلام فيه.
وإن كان قبله، فإن خرج عن هيئة الركوع ولو جالساً قام مطمئناً، ثمّ سجد، وسقط عنه ذكر الركوع، وإن لم يخرج عن ذلك ففي وجوب قيامه منحنياً لأداء الذكر الواجب إشكال: من أنّ ذلك يعدّ ركوعاً جديداً، أو هو بقاء للركوع الأول.
غاية ما هنالك: أنّه تغيّر وصفه، وهو كونه ركوعاً قياميّاً الى الركوع القعودي، فالرجوع لا يكون إلاّ إحداثاً للوصف الزائد، لا الموصوف، فتأمّل.
وإن هوى قبل أن يحصل سكون، فإن قلنا: إنّ الطمأنينة في الركوع ركن فسد
صلاته بعد الدخول في السجود على إشكال فيه مرت الإشارة اليه.
وإن قلنا: إنّه ليس بركنٍ صحّ، وكذلك الكلام حيث يخرج عن الركوع، ويمكن الفرق بين جهات الحركة، فيقال: إن تحقّق سكون من جهة الهوي الى السفل وان لم يحصل الاستقرار من سائر الجهات حصل الركوع، وإلاّ فلم يحصل، وللنظر في جميع هذه الفروع مجال، فليتأمّل فيها.
ولو تذكر بعد الخروج عن الحدّ الذي يمكن جعله ركوعاً وجب الاستواء قائماً، ثمّ الركوع، لأنّه أتى بأمر زائد عن الهوي، فصار فاصلاً بين القيام والركوع، فتأمّل.
مسألة: لو علم أنّه ترك سجدةً، وهو قائم في الركعة المتأخّرة وجب الرجوع والإتيان بها، وأمّا الجلوس بين السجدتين، فإن علم أنّه فعله بنيّته، ثمّ عرضت له الغفلة عن الثانية فلا إشكال، ولو علم أنّه أتى به بنيّة الاستراحة، فإن قلنا: إنّ ماهيّة الجلوسين متغايرة وجبت الإعادة، لكنّه محض احتمال، لا أظنّ أحداً يلتزم به.
وإن قلنا باتحاد ماهيّتهما، كما هو الأقوى فالظاهر عدم وجوب الإعادة، لأنّه عمل وقع بنيّة امتثال الأمر مطابقاً له، واعتقاد كونه جلسةً بعد السجدة الثانية ليس بأولى من اعتقاد كون السجدة السابقة على هذه الجلسة سجدة ثانية، والظاهر عدم الإشكال في عدم وجوب إعادة السجدة المأتيّ بها بمجرّد اعتقاد كونها ثانيةً، وهذا ظاهر.
ولو علم أنّه لم يتحقّق منه جلوس فالظاهر وجوب الجلوس قبل الإتيان بالسجدة.
وقد يقال: لا يجب ذلك، لإطلاق الأخبار الآمرة بالإتيان بالسجدة من غير ذكر للجلوس، ولأنّ المناط في وجوب الجلوس هو الفصل الحاصل بالقيام، ولا يخفى ما في الوجهين، لعدم سوق الأخبار لبيان حكم الجلوس. ولو كان المناط الفصل لجاز ذلك اختياراً، ولا يلتزم به أحد.
ولو شكّ في الجلوس فقد يقال بوجوب الإتيان لقاعدة الاشتغال، ولأنّه شكّ
قبل الفراغ بعد فرض لغويّة القيام.
إلاّ أن يقال: إنّ هذا القيام خروج عن محلّ الجلوس، ومجرّد كونه لغواً - غير صالح لجزئية الصلاة - لا ينافي كونه موجباً لجواز محلّ الجلوس بملاحظة الشكّ، لأنّ مناطه الدخول في فعلٍ مرتّب عليه.
إلاّ أن يقال: ذات القيام غير مترتّب على الجلوس، لجوازه لا بنيّة جزئية الصلاة قبله، ومجرد النيّة غير مجدٍ في تجاوز المحلّ.
وفيه: أنّ الدخول في الغير مناطه عنوان العمل، ولذا لو كان داخلاً في ذكر لا ينافي الصلاة وأجزائها في ذاته، لكن أتى به بعنوان التعقيب(١) لزم فيه تجاوز محلّ السلام وإن كان إتيانه لا بذلك العنوان غير موجب له.
وعلى هذا، فلو علم بترك سجدة في حال القيام، وشكّ في ترك الاخرى لم يلزم عليه الإتيان بسجدتين، وفيه إشكال، والاحوط إتمام الصلاة بسجدةٍ واحدةٍ، ثمّ الإعادة.
ثم إنّه يستثنى من حكم الجلسة من أتى بها بعنوان الاستحباب، متقيّداً به في قصده، فأنّ الظاهر وجوب إعادة الجلسة عليه، لأنّه نوى بما أتى به أولاً غير أمره، ولعلّ ذلك منشأ إشكال من أوجب الإعادة مطلقاً، فتأمّل جيّداً. ومع الشك في تقييد قصده تجب الإعادة احتياطاً لقاعدة الاشتغال، الاّ أن يتمسّك بأصالة الصحة والشك بعد الفراغ، فتأمّل جيّداً.
مسألة: لو شكّ في النافلة المنذورة فالظاهر أنّه مخيّر، لأنّه « لا شكّ في النافلة »، ودعوى أنّ النافلة بمعنى الزائدة، أو المستحبّة، ويخرج بعروض الوجوب عن كونها زائدة، أو مستحبّة مدفوعة بأنّ الظاهر هو الزائدة والمستحبة بحسب الذات، ولذا لو وجبت النافلة بسبب أمر الوالدين لا أظنّ أحداً يلتزم فيه بحكم الفرض.
إلاّ أن يقال: إنّ الوجوب القابل للزوال ليس كالوجوب الثابت الذي
____________________
(١) في « ط ١ »: « أتى بعنوان التعقب »، وما أثبتناه هو الصحيح وكما في « ط ٢ ».
لا يسقط، إلاّ بالامتثال.
والحاصل: أنّ شمول نفي الشكّ في النافلة للمنذورة مشكل، خصوصاً فيما لو كان النذر متعلّقاً بنافلةٍ شخصيّةٍ، لا بإتيان نافلةٍ، فأتى بنافلة أداء لما في ذمّته من كلّيّ الركعتين ، وعموم التعليل في قولهعليهالسلام : « لأنّها ركعتان »(١) يشمل النفل والفرض.
إلاّ أن يقال: إنّ مصبّ التعليل هو الفرض، وفيه منع. وتوهّم وجوب البناء على الأقلّ تمسّكاً بالأصل بعد الشكّ في شمول أدلّة النافلة والمفروضة، مدفوعة بأنّ المنذورة داخلة في أحد الحكمين، فالأصل معلوم الانتقاض بحكم أحد الشكّين، إلاّ أن يحتمل خروجه واقعاً عن كلا الحكمين، وهو بعيد.
أو يقال: إنّ احتمال الزيادة لا يرتفع بالأصل، لأنّها اخذت صفةً للركعتين، وفيه منع، سيأتي الكلام فيه - إن شاء اللّه -.
وكيف كان، فالقول بالتخيير لا يخلو عن قوّةٍ، ويؤيّده استصحاب التخيير لو كان النذر متعلّقاً بنافلةٍ شخصيّة.
وتقريره أن يقال: حكم الشكّ في هذه النافلة الشخصيّة قبل تعلّق النذر به كان هو التخيير فهو باقٍ بحكم الاستصحاب.
إلاّ أن يقال: موضوع التخيير يحتمل أن يكون هو النافلة بوصف نفليّة النفل، فتأمّل.
مسألة: لو حكم على الصلاة المشكوك فيها بالإعادة فهل تجوز الإعادة قبل فعل المبطل مطلقاً، أو لا تجوز مطلقاً، أو يفصل بين ما امر فيه بالإعادة شرعاً كالشكوك المنصوصة، وبين المواضع التي يحكم فيها بالإعادة لقاعدة الاشتغال كالمنذورة إن قلنا فيها بذلك، للشكّ في شمول أدلّة النافلة، وأدلة الفريضة؟ وجوه: ولعلّ الأقوى هو الأول، أمّا في الموارد المنصوصة فلإطلاق النصوص، بل مقتضى إطلاقها صحة
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب بطلان الصبح والجمعة والمغرب ح ٨، ج ٥، ص ٣٠٥.
الثانية. ولو تبيّن حال الصلاة الاولى قبل الفراغ عن الثانية، ومقتضاه أن يكون الشكّ مبطلاً مراعى بالدخول في الثانية.
وأمّا في غيرها فلأنّ المانع عن الدخول في الثانية قبل إبطال الاولى، أمّا كون الأجزاء المأتيّ بها غير قابلةٍ للتكرار للاجزاء، وفيه منع بالنسبة الى الأوامر الغيريّة، وأمّا كونها - حينئذٍ - زيادةً مبطلةً للاولى فتحرم، وفيه منع أيضاً، إذ لا دليل على حرمة إبطال ما لا يمكن الامتثال به اذا الكلام بعد اليأس عن حصول العلم بأحد طرفي ما يشكّ فيه، من غير فرقٍ بين خروجه عن قابلية الامتثال كالتي حدث فيها قاطع، أو لم يمكن إتمامه لعدم تهيّؤ أسباب الإتمام، كمن شكّ في عدد الركعات إن قلنا: إنّ الحفظ في حال الأداء شرط، أو لعدم القدرة على حصول العلم بالامتثال كالفرض إن قلنا: إنّ الحفظ ليس بشرط وإنّ الإعادة إنما هو لأجل اليقين بحصول الإمتثال، فتأمّل.
مع أنّ كونها زيادةً مبطلةً محلّ منع، إذ لم يقصد منها الجزئيّة لما وقع فيه الشك، إلاّ أن يستظهر الإتفاق من قولهم في باب التكبير: (إنّ من كرّر الافتتاح انعقد بالثانية)(١) من غير فرقٍ بين أن ينوي استئناف فردٍ جديدٍ، أم لا، أنّ مثل ذلك زيادة، فتأمّل.
أو يقال: إنّ زيادة التكبير للافتتاح لا يعقل في صورة العمد إلاّ بقصد إيقاع فردٍ آخر، فتأمّل.
ثم إنّه لو تبيّن بعد الاشتغال بالثانية حال الصلاة الاولى فالظاهر الحكم ببطلان الاولى، وصحة الثانية في مواقع القصد بالإعادة كما عرفت.
وأمّا في غيرها، فإن قلنا: إنّ الدخول في الثانية أبطل الاولى فلا إشكال أيضاً، وإن قلنا: إنّها باقية على الصحة أمكن الحكم بتخيير المصلّي بين إتمام الاولى والثانية، ولكن لا أظنّ القوم يلتزمون به، والظاهر فساد المبنى، لا المبنى عليه.
____________________
(١) في (ط ٢): « بالثالثة ».
فتأمّل خصوصاً اذا أتى بالسجدة للصلاة الثانية، لأنّ قولهعليهالسلام في المنع عن سجدة القرآن بأنها « زيادة في المكتوبة »(١) كالصريح في أنّ السجدة بعنوان صلاة اخرى زيادة، وفيه تأمل.
مسألة: الظاهر وجوب الترويّ، فلا يجوز الإعادة، ولا البناء على الأكثر قبله، لأنّ الظاهر من الأدلة أنّها علاج المتحيّر، وهو منصرف الى عدم التمكّن من رفع تحيّره بطريقٍ عقليّ، ويؤيّده قولهعليهالسلام : « اذا لم تدر كم صليت، ولم يقع وهمك على شيء »(٢) فلو أعاد قبله وقع مبطلاً لأنّه تعمّد في زيادة الركن فيكون باطلاً لحرمته.
نعم، إن قلنا: إنّ الزيادة المبطلة ما يقع جزءً للصلاة الشخصيّة أمكن أن يقال: إنّه غير محرّمٍ وصحيح في نفسه، وحكمه يظهر من التأمّل في بعض المسائل المتقدّمة.
ولو بنى على الأكثر، وأتى بفعلٍ بهذا البناء كان مشروعاً، وكان فعله محرّماً إن قلنا: إنّ الحرمة التشريعية تسري الى العمل، فيكون مبطلاً اذا كان كلاماً من وجهين: من حيث أنّه زيادة عمديّة، ومن حيث أنّه كلام محرّم، واذا كان فعلاً انحصر وجه البطلان في الزيادة.
ولو أتى لا بعنوان البناء أنّه مأمور به شرعاً بذلك، فإن أتى بالفرد المشتمل على ما يأتي لاحتمال المطلوبيّة ناوياً للجزئيّة على وجه الجزم بطل العمل، من حيث أنّه مع تمكّنه من الجزم بالوجه الواقعي، أو الظاهري لم ينو الوجه، فيكون زيادة عمديّة، وإن أتى به باحتمال الجزئيّة بطل بنفسه، ولم يقع مبطلاً إلاّ فيما علم أن وقوعه في الصلاة ولو لم يقع جزء مبطل كالسجود، نظراً الى التعليل الوارد في بطلان الصلاة بسجدة القراءة.
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب عدم جواز قراءة سورة من العزائم، في الفريضة ح ١، ج ٤، ص ٧٧٩.
(٢) وسائل الشيعة: ب وجوب الاعادة على من لم يدر كم صلّى ح ١، ج ٥، ص ٣٢٧.
(مثاله: ما لو شكّ بين الاثنين والثلاث، وعلم أنّه إن كانت الركعة المتلبّس بها ركعةً ثانيةً فهو آتٍ بالسجدتين، وإن كانت ركعةً ثالثةً لم يأت بالسجدة الثانية)(١) .
هذا كلّه اذا كان المأتيّ به منافياً لاحتمال النقص. وأمّا لو أتى بالفعل المشترك بين الاحتمالين، كمن شكّ بين الثلاث والأربع قبل الإكمال، فأتى بالمشترك فالظاهر أنّ الحكم ببطلان الصلاة به اذا نوى الأمر الواقعيّ من غير نظرٍ الى البناء، وأحكام الشكوك لا وجه له.
(و)(٢) مثل (ذلك)(٣) ما لو أتى في الشكوك المبطلة متروّياً بعض الأفعال المشتركة، فحصل له الظنّ بطرفٍ فأنّ الحكم بفساد ما أتى به (حينئذٍ)(٤) مشكل.
إلاّ أن يقال: إنّ المستفاد من أدلّة وجوب الحفظ، وأدلّة اعتبار الظنّ في الأوليين أنّه يجب الإتيان بهما: إمّا ظانّاً أو عالماً، وفيه منع، لإمكان أن يقال: إنّ الإتيان بالركعة بعد استقرار الشكّ لا يجوز، وأمّا قبله فلا، فمانعية الشكّ حال الترويّ غير معلوم.
أو يقال: إنّ صحة الأجزاء المأتيّ بها حال الترويّ مراعى بحصول الطريق، وحيث يجهل حصولها لا يمكن الجزم بمطابقتها للأمر الواقعي، فتفسد من هذه الجهة، إلاّ أن يمنع اعتبار الجزم لمن لا يتمكّن من الجزم، ولا يعلم بأنّه يحصل له طريق يوجب الجزم.
أو يقال: إنّ ظاهر الأخبار انحصار التكليف في الإعادة أو الأخذ بالظنّ، فالعمل بالنسبة الى هذا المتردّد مشروط بكونه ظانّاً، ويقال في الشكوك الصحيحة أيضاً: إنّ الظاهر من الأخبار انحصار التكليف في البناء، أو الأخذ بالظن، ولكنّ ظهورها في ذلك على وجهٍ تسكن اليه النفس ممنوع.
____________________
(١) هذه الزيادة أثبتناها من « ط ٢ ».
(٢) و (٣) و (٤) أثبتناها من « ط ٢ ».
وكيف كان، فالأحوط الاجتناب، وأوضح ممّا ذكرنا، ما لو علم بأنّه لو انتقل من حالةٍ الى اخرى يحصل له الطريق عقلاً، أو شرعاً لتعيين أحد الاحتمالين كالمأموم الذي لا يتمكّن من الاستعلام للحال من الإمام، ويعلم أنه يتبيّن الحال (بالانتقال، وكالمنفرد الذي نصب علامةً لا يمكن له التبيّن منها إلاّ بعد الانتقال عن حاله)(١) بانتقال عن حاله، فأنّ حرمة الجري على الشكّ على مثله ممنوعة، بل لو بنى الفرضين على ما يتبيّن له، وجرى أمكن أن يقال: إنّه يخرج عن الجري على الشك موضوعاً، فتأمّل. والمسألة بجميع فروعها محتاجة الى التأمّل، وكذا لو علم بأنّه لو انتقل من حالةٍ الى اخرى يحصل له الظنّ بشيء.
ودعوى خروج عمله، مع البناء على عنوان ما يحصل (له)(٢) الظنّ به عن الجري على الشكّ - هنا - أشدّ إشكالاً من الفرضين السابقين، فتأمّل.
مسألة: لا إشكال، ولا خلاف نصّاً وفتوىً في أنّ العمل بالظنّ في الأخيرتين متعيّن، وأمّا الاولتين فكذلك، خلافاً للمحكيّ عن السرائر(٣) للنبويّ: « اذا شكّ أحدكم في الصلاة فلينظر أيّ ذلك أحرى فليبن عليه »(٤) ولقولهعليهالسلام : « اذا لم تدر كم صليت، ولم يقع وهمك على شيء فأعد »(٥) والمراد به: إمّا خصوص ما جرى عليه مصطلح الفقهاء، وهو التردّد بين احتمالات كثيرةٍ، أو مطلق الشكّ المرتبط بالأوّلتين.
وعلى أيّ حال، فهي واضحة الدلالة على اعتبار الظنّ في الأوّلتين مطلقاً، أو في الجملة فيتمّ بعدم الفصل، وعلى أيّ حال يجب تقديمها على أدلّة اعتبار الحفظ في الاوّلتين، لانها: إمّا حاكمة عليها بناءاً على أنّ الظنّ طريق، أو مخصّص لها.
____________________
(١) هذه الزيادة أثبتناها من « ط ٢ ».
(٢) أثبتناها من « ط ٢ ».
(٣) السرائر: في احكام الشكّ ج ١، ص ٢٤٥.
(٤) وردت هذه الرواية في بدائع الصنائع: ج ١، ص ١٦٥، نقل ذلك صاحب الحدائق: ج ٩، ص ٢٠٦.
(٥) وسائل الشيعة: ب وجوب الاعادة على من لم يدر كم صلى ح ١، ج ٥، ص ٣٢٧.
لا يقال: النسبة بين هذه الرواية وأدلّة الحفظ عموم من وجه، لشمولها للأخيرتين، والمرجع بعد التساقط أصالة عدم طريقيّة الظنّ، ومجرّد أصالة البراءة عن اشتراط الحفظ، مع وجود الظنّ لا يجدي في دفع التحيّر في مقام العمل من حيث الشكّ في الركعة.
لأنّا نقول: إيجاب الإعادة على تقدير عدم الظن قرينة على أنّ المراد من الرواية الشكّ في الاوّلتين.
وهل(١) الظن طريق، أو العمل على طبقه واجب تعبّداً ؟ الظاهر الأوّل، لظهور تعبيرات الأخبار في ذلك فأنّ عدم بيان ما يجب فعله - على تقدير وقوع الوهم(٢) ، وإيكاله الى فهم المخاطب - قرينة عرفية على تصديق المتكلّم لما في ذهن المخاطب، من أنّ الظنّ ملحوظ طريقاً اعتبر به، أو لم يعتبر به لنقصه مضافاً الى بعد التعبّد المحض في نفسه.
مسألة: قد عرفت أن الظنّ بعدد الركعات معتبر شرعاً.
وهل هو معتبر في الأفعال؟ المشهور نعم، بل لم ينسب الخلاف فيه الى أحدٍ حتى السرائر(٣) ، بل حكي(٤) اتّفاق الأصحاب على اعتبار الظنّ فيها، وفي الركعات عن بعض، والإجماع(٥) عن بعض آخر.
ويدلّ عليه النبويّ(٦) السابق، سواء قلنا: إنّ المراد من الشكّ في الصلاة الشكّ الواقع فيها، أو الشكّ المتعلّق بها، ضرورة أنّه ليس على الثاني المراد الشكّ في وجود أصل الصلاة، لعدم اعتبار الظنّ في ذلك إجماعاً، فالمراد الشكّ فيها باعتبار
____________________
(١) في « ط ١ »: « وهذا » وما أثبتناه كما في « ط ٢ ».
(٢) أثبتناها من « ط ٢ ».
(٣) السرائر: في احكام الشك ج ١، ص ٢٥٢ - ٢٥٦.
(٤) مفاتيح الشرائع: حكم الشكّ في عدد الركعات ج ١، ص ١٧٨.
(٥) الذكرى: القول في الشكيّات ص ٢٢٢، س ٣١، ظاهره الاجماع.
(٦) وردت الرواية في بدائع الصنائع: ج ١، ص ١٦٥، نقل ذلك صاحب الحدائق: ج ٩، ص ٢٠٦.
وضعها، وكما هو يشمل الشكّ في صحتها من جهة ترك الركن، فاذا اعتبر الظنّ من هذه الجهة اعتبر في سائر الأجزاء قطعاً.
ودعوى انصرافه الى الشك(١) في خصوص عدد الركعات على التقدير الثاني، أو مطلقاً ممنوعة جدّاً، وإنّما الإشكال في سندها، إلاّ أن يدّعى انجباره باستناد المعتبر(٢) والتذكرة(٣) وبعض اخر من الأصحاب اليه، مع مطابقته لفتوى المشهور، وفيه تأمّل.
وقد يقال: إنّ الظنّ اذا كان حجّةً في عدد الركعات كان بالحجّية في أفعال الصلاة أولى قطعاً (لأنّ الركعة ليست الى مجموع الأفعال، فاذا اعتبر في المجموع كان بالحجّيّة في أبعاضها أولى)(٤) لهذا(٥) يمكن عدّه من دلالة اللفظ بالمفهوم، ولأنّ اعتباره في الأجزاء بنيّة(٦) الاجزاء واقعاً في غير الأركان وإن حصل به خلل، لأنّه معدود من السهو، ولا فرق قطعاً بين الأركان، وغيرها من الأجزاء، ولأنّ الاوّلتين إنّما لم يعتبر الشك فيهما، لكونهما فرض اللّه، كما نصّ(٧) به كثير من الأخبار، فاذا اعتبر الظنّ فيهما - كما عرفت - كان أولى بالإعتبار في القراءة التي هي سنّة، كما نصّ بهعليهالسلام في صدر رواية « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة »(٨) .
وأيضاً، كيف يعتبر الظنّ في الركعة التي لا تسقط بحال، ولا يعتبر في مثل السورة التي هي ساقطة بصدق مسمى الاستعجال؟
____________________
(١) في المصدر: « لا الشك ».
(٢) المعتبر: في الخلل الواقع في الصلاة ج ٢، ص ٣٨٦.
(٣) التذكرة: في احكام الشك ج ١، ص ١٣٥، س ٣٤.
(٤) هذه الزيادة أثبتناها من « ط ٢ ».
(٥) في « ط ١ »: « بل هذا » وما أثبتناه هو الأظهر.
(٦) في « ط ٢ »: يلزمه، والظاهر هو ما أثبتناه.
(٧) وسائل الشيعة: ب ابواب اعداد الفرائض ونوافلها ح ٢٢، ج ٣، ص ٣٨.
(٨) وسائل الشيعة: ب عدم وجوب الاعادة على من نسى القراءة ح ٥، ج ٤، ص ٧٧٠.
وأيضاً ، اذا فرضنا أنّه كان المصلّي شاكّاً بين الاثنين والثلاث ، وكان شاكّاً في أنّه فعل السجدة من الركعة التي (هو)(١) تلبّس بها أم لا، وظنّ أنّه لو فعل السجدة كانت الركعة المتلبس بها ثالثةً مثلاً، وظنّ أنّه فعل السجدة فهل ترى أنّه يأخذ بظنّه بأن الركعة ثالثة لأدلّة اعتبار الظنّ في الركعات، ولا يفهم منها أنّه لا تجب عليه السجدة، ويبني - حينئذٍ - على أنّ السجدة(٢) لقاعدة الشك قبل الفراغ بل يلزم في بعض فروض التفكيك بين الأخذ بالظنّ في الركعات، وعدمه في الأفعال الحكم بفساد الصلاة، للعلم بزيادة الركن فيها، أو نقصه. ولا أظنّ فقيهاً يلتزم به، وربمّا يستأنس لذلك بما ورد في تعليل الشك بعد الفراغ « فأنّه حين يتوضأ اذكر (منه)(٣) من حين يشك »(٤) .
وفيه: أنّ الأخذ بالظنّ في مورد التعليل، وهو أفعال الوضوء خلاف الإجماع ظاهراً، ولعلّ المناط ليس مطلق الأمارة، بل هو الظنّ النوعيّ الحاصل من اذكريّته حين العمل، وبأن المأموم يتبع في الأفعال عند الشك فيها، وفيه منع، وبما(٥) ورد في تعليل عدم العبرة بكثرة الشكّ « بأنّه من الشيطان »(٦) ، الظاهر في أنّ المناط الظن، وفيه: أنّ عدم اعتبار كثرة الشكّ سار في جميع امور المعاد والمعاش، ولا إشكال في أنّ مطلق الظنّ من أيّ سبب حصل غير معتبر فيها.
وبما ورد في اعتبار قول الصبيّ في عدد أشواط الطواف(٧) ، الظاهر في اعتبار قوله في سائر ما يرجع الى الطواف من الشرائط والأجزاء، ويتمّ في الصلاة بعكس
____________________
(١) أثبتناها من « ط ٢ ».
(٢) في « ط ٢ »: « أن يسجد » وما في المتن هو الأظهر.
(٣) أضفناها من المصدر لضرورتها في المحلّ.
(٤) وسائل الشيعة: ب ان من شك في شيء من افعال الوضوء ح ٧، ج ١، ص ٣٣٢.
(٥) في « ط ١ »: « وربّما » وما في المتن هوالأصحّ.
(٦) وسائل الشيعة: ب عدم وجوب الاحتياط على من كثر سهوه ح ٢، ج٥ ، ص ٣٢٩.
(٧) وسائل الشيعة: ب عدم وجوب شيء بسهو الامام ح ٩، ج ٥ ، ص ٣٤٠.
التشبيه، وفي سائر أسباب الظنّ بعدم الفصل.
ودعوى أنّ أخبار الطواف ليست بأولى من أخبار اعتبار الظنّ في الركعات، فاذا منع استفادة التعدّي منها الى الظنّ في الأفعال كان الأمر فيها - أيضاً - كذلك.
يدفعه اختلاف سياق تلك الأخبار مع هذه، فليتأمل فيها. والمسألة محتاجة الى التأمّل، ولعلّ اللّه يوفّقنا لتنقيحها بعد حين.
مسألة: اذا تساوى طرفا ما شكّ فيه حكم بالبطلان، ما لم يحرز الاوّلتين، وبعد إحرازهما يبنى على الأكثر. وسيأتي تفصيلها - إن شاء اللّه - والكلام - حينئذٍ - في ما به يحرز الاوليان.
فقد يقال: إنّه بالدخول في ركوع الثانية. وقد يقال بالدخول في السجدة (الثانية)(١) من الثانية. وقد يقال: بالفراغ من الذكر الواجب منها. وقد يقال برفع الرأس منها.
وربّما أمكن أن يقال: إنّ جلسة الاستراحة إن عدّت من الركعة الثالثة كان إكمالها - حينئذٍ - بالفراغ منها الحاصل بالنهوض الى القيام للرابعة، وربّما يؤيّده حكمهعليهالسلام بالصحة، فيمن شكّ بين الاثنين والثلاثة إن دخل في الثالثة(٢) ، المحمول على الفراغ التامّ من الثانية، الحاصل بالنهوض للقيام. ولكنّ الظاهر أنّه لم يقل أحد بذلك، بل الظاهر من أخبار الشكّ بين الاثنين والأربع، والشك بين الاثنين والثلاث والأربع، الحاكمة بالبناء على الأربع عدم العبرة بذلك، فتأمل.
وكيف كان، فظاهر حفظ الاوّلتين، وعدم كون الشكّ في وجودهما وجوب حصول العلم بحصول تمام الأجزاء الواجبة للركعة، الحاصلة بالعلم بالفراغ من الذكر الواجب للسجدة الثانية.
____________________
(١) أثبتناها من « ط ٢ ».
(٢) وسائل الشيعة: ب ان من شك بين الثنتين والثلاث ح ١، ج ٥، ص ٣١٩.
ودعوى أنّه يصدق اذا كان شاكّاً في أنّ الركعة المتلبّس بها، الفارغ من واجباتها (أنّها) الثانية، أو الثالثة أنّه شاكّ في وجود الثانية، لأنّ وجودها بعد لم يتمّ.
مدفوعة بأنّ وجود الواجب من الثانية، الذي هو داخل في فرض اللّه، الذي لا يقع فيه الشكّ معلوم الحصول، فالشك(١) بملاحظة الركعات الملتئمة منها الصلاة راجع الى الشكّ في وجود ما سنّه النبيّصلىاللهعليهوآله بعد القطع بأنّ فرض اللّه بكماله قد وجد، ومجرّد قابلية لحوق شيء بالثانية لا يوجب صدق الشك في وجود الثانية.
وممّا يدلّ على ما ذكرنا قولهعليهالسلام في صحيحة زرارة، عن أبي جعفر: « كان الذي فرض اللّه على العباد عشر ركعاتٍ، وفيهنّ القراءة، وليس فيهنّ وهم - يعنى سهواً - فزاد رسول اللّه سبعاً، وفيهنّ الوهم، وليس فيهنّ قراءة »(٢) فمن شكّ في الأوّلتين أعاد حتى يحفظ، ويكون على يقينٍ، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم.
لا يقال: المراد (من الشك في الاوليين الشكّ الواقع في الاوليين، ويؤيّده قولهعليهالسلام : ليس فيهن)(٣) وهم.
لأنّا نقول: هذا خلاف الظاهر، ولو كان كما ذكر أيضاً لم يوجب الحكم بالفساد، لأنّه لا يعلم أنّ شكّه وقع في الثانية، مع احتمال كون الركعة المتلبّس بها، التي وقع فيها (الشكّ)(٤) ثالثة، إلاّ من باب التخيير والأصل، فتأمل.
وقولهعليهالسلام « ليس فيهنّ وهم » معناه ليس فيهنّ (حكم)(٥) الوهم، وهو
____________________
(١) في « ط ١ »: « وأما بملاحظة » وما أثبتناه كما في « ط ٢ ».
(٢) وسائل الشيعة: ب عدد الفرائض اليومية ونوافلها ح ١٢، ج ٣، ص ٣٤، نقلاً بالمضمون.
(٣) هذه الاضافة أثبتناها من « ط ٢ ».
(٤) و (٥) أثبتناهما من « ط ٢ ».
البناء على الأكثر، والاحتياط بعد الفراغ.
وبالجملة: ظاهر كثير من الأخبار أنّ مناط الفساد كون الشكّ في وجود الاوليين.
ودعوى أنّ المناط أن لا يقع شيء من الاوليين، ولو جزءه المستحبّ بصورة الشكّ في عنوانه مدفوعة بعدم الدليل، بل إطلاق قولهعليهالسلام في رواية عبد الرحمان بن الحجاج: رجل لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثاً أو اربعاً، فقال: « يصلي ركعةً من قيام، وركعتين من جلوس »)(١) .
وقولهعليهالسلام في رواية ابن أبي عمير عن هذه المسألة: « يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلّم، وركعتين من جلوس »(٢) يوجب العمل على الأكثر، حيث صدق أنّه صلّى ركعتين، ولا يدري أنّه صلى الثالثة والرابعة أم لا، فتأمل في ذلك.
وأمّا القول بأنّ كمال الركعة بحصول السجدة الثانية، لأن ترك الذكر نسياناً مفتقر، فهو ضعيف، وإلاّ كانت العبرة بالدخول في السجدة الاولى، كما لا يخفى.
ومثله في الضعف دعوى أنّ الركعة اسم للركوع، فاذا دخل في الركوع الثاني فقد أكمل فرض اللّه، الذي ليس فيه الوهم.
وفيه: أنّ الظاهر من الركعة في هذه الأخبار هو المجموع المشتمل على السجدتين وذكرهما، فانتفاء الشكّ في وجودهما ملازم لليقين بوجود جميع ما يعتبر فيهما.
مسائل
الاولى: من شكّ بين الاثنين والثلاث بعد الاكمال بنى على الثلاث،
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب ان من شك بين الثنتين والثلاث والاربع ح ١، ج ٥، ص ٣٢٥، مع اختلاف يسير.
(٢) وسائل الشيعة: ب ان من شك بين الثنتين والثلاث والاربع ح ٤، ج ٥، ص ٣٢٦ ، مع اختلاف يسير.
واحتاط بإتمام ما يحتمل نقصه، للاطلاقات الكثيرة الدالّة على ذلك، وخصوص رواية قرب الاسناد، عن أبي عبد اللّهعليهالسلام ، قال: قلت: رجل صلّى ركعتين، وشكّ في الثالثة، قال: « يبني على اليقين، فاذا فرغ تشهّد، وقام فصلى ركعةً بفاتحة القرآن »(١) وبأزائها روايات، إمّا مجملة أو مخالفة لهذه، محمولة على وجوه: اوجهها التقية.
وهل مخيّر في الاحتياط بين الركعة من قيام وركعتين من جلوس، أو يتعيّن الاولى كما هو ظاهر المطلقات، أو الأخيرة كما هو ظاهر كثير من الأخبار في المسألة الثانية؟ بناء على عدم الفرق بينهما وجوه.
الثانية: من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع مطلقاً بغير إشكال، روايةً وفتوىً، إلاّ عن ابن بابويه(٢) ، واحتاط بركعةٍ من قيام، أو ركعتين من جلوس،ٍ كما هو المشهور.
وعن بعض(٣) القدماء تعيّن الركعة من قيام، ولعلّ وجهه المطلقات.
وقولهعليهالسلام (في)(٤) رواية عمار، عن أبي عبد اللّهعليهالسلام أنّه قال: « يا عمار، أجمع لك السهو كلّه في كلمتين، متى شككت فخذ بالأكثر، فاذا سلّمت فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت »(٥) .
وفي روايةٍ اخرى له، عن أبي عبد اللّهعليهالسلام ، قال: سألت أبا عبد اللّهعليهالسلام عن شيء من السهو في الصلاة، فقالعليهالسلام : « ألاّ اعلّمك شيئاً اذا فعلته، ثم ذكرت أنّك أتممت، أو نقصت لم يكن عليك شيء؟ قلت: بلى، قال:
____________________
(١) قرب الاسناد: ص ١٦، س ٣.
(٢) المقنع (الجوامع الفقهية): باب السهو في الصلاة ص ٩، س ٣.
(٣) لا يوجد لدينا كتاب المسائل الغريّة وحكاه عنه الشهيد في الذكرى: في احكام الشكوك ص ٢٢٦، س ٣٠.
(٤) أثبتناها من « ط ٢ ».
(٥) وسائل الشيعة: ب وجوب البناء على الاكثر عند الشك ح ١، ج ٥، ص ٣١٧.
اذا سهوت فابن على الأكثر، فاذا فرغت، وسلمت، فقم، فصل ما ظننت أنّك نقصت، فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شي،، وإن ذكرت أنّك كنت نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت »(١) وبمعناهما أخبار اخر أيضاً.
وكيف كان، فشمولها لهذه الصورة، والصورة الاولى أظهر من غيرهما، لأنّهما اغلب ما يقع من الوهم، ولا ريب في ظهورهما، خصوصاً الثاني في تعيّن القيام، ومنع دلالة الرواية الاولى مدفوع بأنّ الظاهر إتمام ما نقص بالكيفيّة التي اعتبرت فيها شرعاً، وذلك غير خفيّ.
وحكي عن بعض القدماء(٢) تعيّن الركعتين جلوساً، ووجهه الأخبار المستفيضة الدالّة عليه، ولعلّ الأقوى هو التخيير في هاتين الصورتين، كما هو المشهور لمرسلة جميل، وفيها: « فهو بالخيار إن شاء صلّى ركعةً وهو قائم، وإن شاء صلّى ركعتين وأربع سجداتٍ وهو جالس »(٣) .
ولو قيل: إنّ هذه مرسلة، اجيب عنه: بأنّ عمل الأصحاب يجبره، مع أنّ إباء المطلقات عن التخصيص، خصوصاً بالنسبة الى هاتين الصورتين، وصراحة المقيّدات في جواز الجلوس في الصورة الثانية، وعدم الفرق بينها وبين الاولى يوجب حمل المطلقات على الوجوب التخييري، مع إمكان أن يقال: ندرة المخالف في المسألتين يغني عن تكلّف الاستدلال، فتأمل. والأحوط في الصورة الاولى القيام، لأنّ دلالة(٤) المطلقات تامّة، ولا معارض لها فيها، إلاّ عدم القول بالفصل بينها وبين الصورة الثانية.
كما أنّ الأحوط فيها الجلوس لنصوصيّة الأخبار الخاصّة في الجلوس، وإباء
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب وجوب البناء على الأكثر عند الشك ح ٣، ج ٥، ص ٣١٨.
(٢) حكاه العلاّمة عن ابن أبي عقيل في المختلف: في السهو والشك ج ١، ص ١٣٣، س ٢٥.
(٣) وسائل الشيعة: ب ان من شك بين الثلاث والاربع ح ٢، ج ٥، ص ٣٢٠.
(٤) في « ط ١ »: « أدلّة » وما أثبتناه هو الموافق للمتن كما في « ط ٢ ».
العمومات عن التخصيص لعلّه بالنسبة الى أصل الحكم، لا خصوصية القيام (أيضاً)(١) كما لا يخفى. ولعّله يأتي لذلك مزيد بيان في المسألة الثالثة إن شاء اللّه تعالى.
الثالثة: من شك بين الاثنين والثلاث والأربع بنى على الاربع، واحتاط بركعتين من قيام، وركعتين من جلوس. وربّما يحتمل الاحتياط بركعةٍ من قيامٍ، وركعتين من جلوس.
فعن الشهيد(٢) : أنّه موافق للاعتبار، وكان غرضه -رحمهالله - من ذلك أنّه تنضمّ الركعتان بالركعة إن كان الناقص ركعتين، ويحسب الزائد نافلةً إن كان الناقص ركعةً واحدةً.
ويدلّ على ذلك رواية ابن الحجاج(٣) ، عن أبي ابراهيمعليهالسلام ، عن أبي عبد اللّهعليهالسلام ، ولكنّها مضافاً الى سندها، وعدم(٤) معهوديّة سؤال أبي ابراهيم، عن أبي عبد اللّهعليهالسلام عن مثل هذه المسألة، وفي متنها من اختلاف النسخة، فأنّ في بعض النسخ كما قيل: بدل ركعةٍ من قيام ركعتين من قيام، وإن كان الأشهر الأوّل معارضته بمرسلة ابن أبي عمير الصريحة في وجوب ركعتين (من قيام وركعتين)(٥) من جلوس(٦) كما أفتى به المشهور ولا ريب أنّها مع ابتناء أصل حجّيّتها على الأخذ بالترجيحات في اختلاف النسخة لا تقاوم المرسلة المعمول بها، التي هي بحكم الصحيح في حدّ نفسها، مع قطع النظر عن اشتهار العمل بها، لكون المرسل(٧) ابن أبي عمير، الذي هو من أصحاب الإجماع، ولا يرسل، أو لا يروي إلاّ عن ثقة.
____________________
(١) من « ط ٢ ».
(٢) الذكرى: في احكام الشكوك ص ٢٢٦، س ٢٨.
(٣) وسائل الشيعة: ب ان من شك بين الاثنين والثلاث والاربع ح ١، ج ٥ ، ٣٢٥.
(٤) في « ط ٢ »: « من عدم ».
(٥) أثبتنا هذه الزيادة من « ط ٢ »
(٦) وسائل الشيعة: ب ان من شك بن الاثنين والثلاث والاربع ح ٤، ج ٥، ص ٣٢٦.
(٧) في « ط ١ »: « المرسلة » تصحيف.
وهل يتعيّن تقديم الركعتين من قيام، أو يجوز تأخيرها؟ الأحوط الأقوى الأوّل، لظهور (ثمّ) في الترتيب.
وربّما يمنع ذلك في عطف الجملة على الجملة بها.
وهل يتعيّن ركعتان من جلوس، أو يجوز تبديلها بركعة من قيام ؟ وجهان:
من ظهور صحيحة ابن الحجاج(١) وابن أبي عمير(٢) في ذلك.
ومن صراحة المطلقات في جواز القيام مع إبائها عن التخصيص، مضافاً الى الاكتفاء بالركعتين من جلوس إنّما هو من جهة بدليتهما من ركعةٍ من قيام، فيبعد تعيّنهما، وعدم جواز الاكتفاء بركعةٍ من قيام.
ولكنّ المشهور هو الأوّل، ولعلّ وجهه ما مرّت الإشارة اليه، من أن إباء المطلقات عن التخصيص بالنسبة الى خصوص القيام ممنوع، ولا شاهد للجمع بينها وبين رواية ابن أبي عمير الظاهرة في تعيّن الجلوس بالحمل على التخيير، مع أنّ ظهورها (في)(٣) تعيّن الجلوس من حيث اقتران الركعتين من جلوس فيها بالركعتين من قيام أقوى من ظهور اخبار المسائل السابقة في تعيّن الجلوس، مع أنّ الفصل بين الركعتين من جلوس، وبين الصلاة بالركعتين من قيام لعلّه أولى من الفصل بين الركعة من قيام وبين الصلاة بهما.
وكيف كان، فالمشهور أحوط إن لم يكن أقوى.
المسألة الرابعة: ان شكّ بين الأربع والخمس، وكان ذلك قبل وصوله الى الركوع فالمشهور هدم هذه الركعة، وعمل الشكّ بين الثلاث والاربع، وذلك إمّا لأنّ بالهدم ينقلب شكّه الى الشكّ بين الثلاث والاربع، أو لأنّه شاكّ في أنّ الركعة التي فرغ منها رابعة أو ثالثة، وأدلّة الشكّ بين الثلاث والأربع أعمّ من أن يكون الشك مرتبطاً بالركعة التي تلبّس بها، أو الركعة التي فرغ منها.
____________________
(١ و ٢) وسائل الشيعة: ب ان من شك بين الاثنين والثلاث والاربع ح ١ و ٤، ج ٥، ص ٣٢٥ و ٣٢٦.
(٣) من « ط ٢ ».
ولذا، لا إشكال في وجوب البناء على الأربع اذا كان شكّه قبل السلام ولو كان بعد الفراغ من التشهّد، أو لأنّ المستفاد من قولهعليهالسلام في بعض الأخبار: « ألا اعلّمك شيئاً »(١) أنّه متى كان أمره دائراً بين احتمال النقص المضرّ يكون علاجه البناء على الأكثر والاحتياط بركعة مستقلة.
ولكن يرد على الأول: أنّ الانقلاب متحقّق حقيقةً اذا لم يشتغل(٢) بالذكر حال القيام نعم ان قلنا ان رفع اليد عن الجزء الذي فعله يجعله كالعدم حقيقة ثم ما ذكر يكن الالتزام به وبلوازمه(٣) مشكل.
وعلى الثاني: بأنّ الظاهر من أدلّة الشكّ بين الثلاث والأربع عدم دخوله في ركعة اخرى.
وعلى الثالث: بأنّ استفادة العموم من تلك الأخبار على وجه يلتزم بلوازمه مشكل فإن من شكّ بين الأربع والخمس، وقد فرغ من الذكر الواجب يعلم أنّ الذي يلزم من البناء على الأكثر نقص الركوع، فاذا احتاط بالركعة المستقلّة يكون إتيانه بالقراءة لا لأجل حاجة الصلاة اليه، بل لرعاية استقلال تلك الصلاة كإتيانه بالتكبير والسلام، واستفادة العموم من تلك الأخبار مشكل.
وقد يقال: إن لازم البناء على الأكثر هو البناء على أنّ الركعة التي تلبّس بها خامسة، فيجب هدمها، لأنّها قبل الركوع غير مضرّة.
وفيه: أنّ المستفاد من البناء على الأكثر هو الأكثر الصحيح، لا الذي يحكم بفساده.
ولكنّ التحقيق ما عليه المشهور، لقولهعليهالسلام في صحيحة زرارة: « من شكّ في الاوليين أعاد حتى يحفظ، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم »(٤) فأنّ
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب وجوب البناء على الاكثر عند الشك ح ٣، ج ٥ ، ص ٣١٨.
(٢) في « ط ١ »: « يستقلّ » وما أثبتناه هو الظاهر كما في « ط ٢ ».
(٣) العبارة في نسختي الأصل مضطربة وركيكة الاسلوب، وما أثبتناه ظاهراً متمّم للمقصود.
(٤) وسائل الشيعة: ب بطلان الصلاة بالشك في عدد الاولتين ح ١، ج ٥، ص ٢٩٩، مع اختلاف يسير.
ظاهره أنّ علاج الشكّ في الأخيرتين هو الاحتياط مرّةً، وحينئذٍ نقول: إنّ الشاكّ بين الأربع والخمس قبل الدخول في الركوع له شبهتان: احداهما: أنّه أتى بالرابعة أم لا، ومن هذه الحيثية حكمه العمل بالوهم. وشبهة اخرى أنّه على تقدير الإتيان بالرابعة أتى بالزائد، والزائد محكوم بأنّه غير مضرّ، لكونه سهواً، وذلك مثل الشاكّ بين الاثنين والثلاث وهو يتشهّد فأنّه يحكم بالثلاث، وأنّ التشهد زائد، ومنه ظهر أنّه يجب في جميع صور الشك التي تقع قبل الركوع، ويرجع - على تقدير الهدم - الى الشكّ الذي يجب فيه البناء على الأكثر(١) والاحتياط كالشك بين الثلاث والأربع والخمس، فأنّه من حيث كونه شكّاً في فراغه من الركعة الرابعة يبني عليه، ويحتاط، ومن حيث الزيادة يبني على كونها سهويّة.
وبعبارة أوضح: أنّ معنى قولهعليهالسلام : « من شكّ في الأخيرتين عمل بالوهم »(٢) أنّه من شكّ في وجود أيّ واحدٍ من الأخيرتين بنى على وجودهما واحتاط بركعةٍ بعد الصلاة، فمن شكّ بين الثلاث والأربع قبل الاكمال يشك في أنّه أتى بالثالثة، وهذه الركعة الناقصة رابعة أم لا، فيجب عليه البناء على أنّه أتى بالثالثة، وأنّ هذه رابعة، وهكذا الحال في الشكّ بين الأربع والخمس، ولا يرد على ذلك الشكّ بين الأربع والخمس بعد الركوع، لأنّ العمل بالوهم هنا غير ممكنٍ، وذلك لأنّ البناء على الإتيان (بالرابعة)(٣) يلزمه زيادة الركن المفسد للصلاة.
ثمّ إنّ الشكوك الغير المنصوصة: إمّا أن يمكن فيها الهدم، وإرجاعه الى الشكّ المنصوص، وإمّا لا يمكن ذلك. اما في الصورة الاولى، فقد يكون الهدم معلوم الوجوب كالشكّ بين الأربع والخمس(٤) والستّ قبل الركوع، فأنّه لعلّه تكون هذه
____________________
(١) في « ط ٢ » زيادة كلمة « الهدم » قبل كلمة « الاحتياط » وذكرناها في الهامش بدل المتن خوف اضطراب المتن.
(٢) وسائل الشيعة: ب بطلان الصلاة بالشك في عدد الاولتين ح ١، ج ٥، ص ٢٩٩.
(٣) أثبتناها من « ط ٢ ».
(٤) في « ط ٢ »: « بين الخمس والثلاث ».
الركعة المتلبّس بها زيادة سهويّة لم تبلغ الى حدّ الفساد ويجب إلغاؤها، فيرجع شكّه الى الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين، فيحكم بالأربع ويعمل عمله، وقد لا يكون كالشكّ بين الثلاث والأربع والخمس قبل الركوع، فأنّه يرجع بالهدم الى الاثنين والثلاث والأربع.
والظاهر - بالنظر الى ما ذكرنا سابقا - أنّه يجب البناء على الأربع بعد الهدم، والاحتياط بركعتين من قيام، وركعتين من جلوس كما لا يخفى.
وأمّا في الصورة الثانية: فقد يكون مركّباً من الشكوك المنصوصة كالشكّ بين الاثنين والأربع والخمس بعد إكمال السجدتين، وكالشكّ بين الثلاث والأربع والخمس كذلك.
والحكم في مثل هذه الصورة يحتمل أن يكون هو الفساد، لعدم النصّ وسقوط الاصول في هذا الباب. ويحتمل البناء على الأربع، وعمل الشك بين الثلاث والأربع والخمس.
أما الأوّل: فلإطلاق قولهعليهالسلام : « من شكّ في الأخيرتين عمل بالوهم »(١) .
وأمّا الثاني: فلما سيأتي في الشك بين الأربع والست بعد إكمال السجدتين. (وقد يكون مركب من المنصوصة وغير المنصوصة كالشك بين الثلاث والأربع والستّ بعد اكمال السجدتين)(٢) . وكالمثال بعد الركوع والحكم فيها بالنسبة الى المنصوصة حكم المنصوص، وبالنسبة الى غيره، فما كان منها بعد إكمال السجدتين فسيأتي الكلام فيه، وما كان منها قبل إكمال السجدتين فالحكم فيه البطلان، إلاّ أن يعمّم ما دلّ على البناء على الأربع عند الشكّ في الزيادة عليه لمثل هذه الصورة.
وسيأتي الكلام عليه - إن شاء اللّه تعالى -.
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب بطلان الصلاة بالشك في عدد الاولتين ح ١، ج ٥، ص ٢٩٩.
(٢) تلك الزيادة اضيفت من « ط ٢ ».
وقد يكون بسيطاً يدور الأمر فيه بين الزيادة والنقيصة كالشك بين الثلاث والخمس بعد الدخول في الركوع، والحكم فيه الفساد، إلاّ أن يعمل بالأصل، ويبنى على الثلاث، وهو خلاف ظاهر الأصحاب.
وقد يكون بسيطاً يدور الأمر فيه بين الزيادة والتمام كالشك بين الأربع وما دون السبع بعد إكمال السجدتين. ويحتمل أصالة الزيادة، فيتمّ بلا سجدة. ويحتمل التمام مع سجدة السهو: إمّا لتنقيح المناط من حكم الشك بين الاربع والخمس، وفيه ما فيه، أو لدعوى دلالة الأخبار عليه كقولهعليهالسلام في صحيحة زرارة، عن أبي جعفر، يقول: « قال رسول اللّهصلىاللهعليهوآله اذا شكّ احدكم في صلاته، فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس »(١) ، وسمّاهما المرغمتين بناءً على أن المراد من الرواية بعد عدم إمكان الأخذ بظاهرها، وهو العلم الإجمالي بحصول أحد الأمرين هو الشك في حصول الزيادة، وعدمها، والنقيصة، وعدمها.
ودعوى إطلاقها بصورة كون الشكّ المذكور بعد الفراغ من الصلاة، أو قبله فيلزمه البناء على الأقلّ في فرض الشكّ في الزيادة (وحدها)(٢) ، وإطلاقها يشمل الشكّ في زيادة ما زاد على الخمس خرج ما زاد على الستّ بالإجماع كما قيل.
وصحيحة الحلبي: « اذا لم تدر أربعا صلّيت، أم خمساً أم زدت أم نقصت فتشهّد، وسلّم، واسجد سجدتين بغير ركوع، ولا قراءة، وتشهّد فيهما تشهداً خفيفاً »(٣) . واحتمال حمل الروايتين على العلم الإجمالي بحصول أحد الأمرين من النقيصة والزيادة، مع فرض كون ما يحتمل زيادةً، أو نقيصة جزء غير ركنٍ ربّما يوهن التمسّك بالروايتين، وعدم الفتوى (بالوجوب)(٤) من المشهور في هذا الفرض
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب ان من شك بين الاربع والخمس ح ٢، ج ٥، ص ٣٢٦.
(٢) أثبتناها من « ط ٢ ».
(٣) وسائل الشيعة: ب ان من شك بين الاربع والخمس فصاعداً ح ٤، ج ٥، ص ٣٢٧.
(٤) زيادة من « ط ٢ ».
لا يمنع الحمل على الاستحباب.
ويحتمل أن يكون المراد من النقيصة في الروايتين عدم الزيادة، فيكون ذكر هذه الفقرة في الرواية ذكر العام بعد الخاصّ.
ورواية زيد الشحّام، قال: « سألته عن رجل صلى العصر خمس ركعاتٍ، أو ستّ ركعاتٍ، قال: إن استيقن أنه صلى خمساً أو ستّاً فليعد، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس، ويركع(١) ركعتين، يقرأ فيهما(٢) بفاتحة الكتاب، ثم يتشهّد »(٣) فإنّ ظاهر الرواية أنّ من لم يدر أنّه نقص، أم زاد وإن كانت الزيادة المحتملة هي الركعة السادسة يجب عليه البناء على الأكثر الصحيح، ويجبر النقص المحتمل بالاحتياط بركعتين من جلوس.
وحمله على خصوص العلم الاجمالي كالشكّ بين الثلاث والخمس الغير القابل للجبر بالاحتياط ظاهر الفساد، بل المراد الشكّ فيهما مع احتمال التمام المنطبق على الشكّ بين الاثنين والأربع وما فوقه، أو بين الثلاث والأربع وما فوقه.
ولا ريب أنّه لا فرق بين صورة الشكّ بين الأربع والستّ مع هذه الصورة، ولكنّ الرواية لا يخلو التمسّك بها عن إشكال: من حيث الاجمال، وعدم عمل الأصحاب بها، فالأحوط في هذه الصورة العمل بالروايات والإعادة احتياطاً. واللّه العالم.
مسألة: هل المناط فيما زاد على الأربع، الذي يحكم فيه بالتمام والصحة، ويسجد سجدتي السهو، لاحتمال الزيادة كالشكّ بين الأربع والخمس أو الأربع والستّ إن قلنا به هو الفراغ عن السجدتين، أو الوصول الى الركوع، أو الفراغ منه، أو الدخول في السجود؟ وجوه:
____________________
(١) في « ط ١ »: « ركع » تصحيف.
(٢) في « ط ١ »: « معهما » وما أثبتناه هو الأظهر كما في « ط ٢ ».
(٣) وسائل الشيعة: ب ان من شك بين الاربع والخمس فصاعداً ح ٥ ، ج ٥، ص ٣٢٧، مع اختلاف يسير.
يشهد للأوّل قولهعليهالسلام : « صلّى خمساً أو أربعاً »(١) فأنّه ظاهر في الأربع والخمس التامّين، مع أنّ الظاهر أنّ سجدتي السهو أنّما شرّعت(٢) هنا تداركاً لاحتمال الزيادة السهويّة، وهو لا يناسب الزيادة مع الالتفات، فتأمل.
والحاصل بعد البناء على أنّ الاصول العمليّة المبنيّة على نفي الزيادة، وعدم المشكوك حصوله مطروحة يكون الأصل في الشكوك البطلان، خصوصاً فيما دار الأمر فيه بين عدم الإتيان بجزء، وبين حصول الزيادة فيما لم يفرغ من تمام الركعة كان الوجه هو البطلان، إلاّ فيما علم شمول النصّ له.
ودعوى أنّ مناط الركعات هو الركوع، أو الدخول في السجود، لأنّ ترك الثانية يغتفر سهواً قد مرّ الكلام عليه.
نعم، الظاهر عدم الحاجة بعد الفراغ عن الذكر الواجب الى شيء، وقد مضى شطر من الكلام في هذا المقام، فتأمّل جيّداً(٣) .
مسألة: قد اشتهر في لسان الفقهاء - رضوان اللّه عليهم - أنّه: (لا سهو في سهو)، وهذا اقتباس من الأخبار، إلاّ أن في بعضها: (لا سهو على سهو)، وفي بعضها كما ذكروا. وكيف كان، الظاهر أنّ كلمة (في سهو) محمول للنسبة المنفيّة كقوله تعالى: (لا ريب فيه)(٤) [ فـ ](٥) (لا) قيد لاسم (لا).
فحاصل المعنى: أنّ السهو ليس محلاً للسهو، والمراد من السهو بقرينة الفقرات الاخر، الواردة في سياقٍ واحدٍ في مرسلة ابراهيم بن هاشم مثل قولهعليهالسلام : « لا سهو في نافلة، ولا سهو في المغرب، ولا سهو في الاولتين »(٦)(٧) هو الاحتياط
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب ان من شك بين الاربع والخمس فصاعداً ح ٣، ج ٥، ص ٣٢٦.
(٢) في الأصل « شرع » وما أثبتناه ملائم في التعبير.
(٣) في « ط ١ »: « جديداً » وهو تصحيف.
(٤) البقرة: ٢.
(٥) أضفناها لضرورة حسن الكلام.
(٦) وسائل الشيعة: ب عدم وجوب شيء بسهو الامام ح ٨، ج ٥، ص ٣٤٠.
(٧) في « ط ١ » سقط من الرواية عبارة « سهو في »، وقد أثبتناها كما في « ط ٢ ».
بركعة منفصلة.
واحتمال إرادة مطلق ما يوجبه السهو بالمعنى الأعمّ من الغفلة والشك، لأنّه - أيضاً - نوع من الغفلة، مخالف لظاهر السياق.
كما أنّ حمل السهو في قوله: « في سهو » على نفس الغفلة، وفي قوله: « لا سهو » على الاحتياط، مع أنّه يحتاج الى نوعٍ من التأويل(١) مخالف لظاهر السياق، فتأمّل.
وبالجملة: هنا مسائل مرتبطة بهذا المقام، ينبغي التعرّض لها:
الاولى: اذا شكّ في عدد ركعات صلاة الاحتياط احتمل البطلان، لأنها ركعتان، والشكّ في كلّ ما كان ركعتين مبطل، كما يشهد به عموم التعليل في بطلان الشكّ في صلاة الجمعة بأنّها ركعتان.
واحتمل البناء على الأقلّ، ويحتمل (البناء) على الأكثر بجعل السهو كأن لم يكن، نظير شكّ كثير الشك، والشك بعد الفراغ.
ويحتمل البناء على الأكثر والاحتياط، والظاهر من الرواية أنّ الاحتياط مرفوع في صلاة الاحتياط، وهو يجامع الاحتمالات الاخر، لكنّ الاوليين مخالفان لظاهر الأصحاب، فيتعيّن الثالث.
الثانية: اذا شك في شيءٍ من أفعال صلاة الاحتياط: فإن كان بعد المحلّ فلا إشكال، وإن كان قبل الفراغ عمل بقاعدة الشكّ قبل الفراغ للشكّ في شمول الرواية للشك في الأفعال.
الثالثة: لو نقص ركعةً سهواً في صلاة الاحتياط، حتى حصل المبطل مطلقاً استأنف الاحتياط إن قلنا: إنّ الفصل بين الصلاة وصلاة الاحتياط غير مبطل، وإلاّ استأنف الصلاة. واحتمال الاغتفار، مع منافاته لحكمة جعل صلاة الاحتياط منافٍ للقواعد بلا دليلٍ يدل عليه، لقصور الرواية(٢) عن إفادة ذلك، ومثل ذلك
____________________
(١) في « ط ١ »: « نوع التأمّل » وما أثبتناه مناسب للمقام، كما في « ط ٢ ».
(٢) وسائل الشيعة: ب عدم وجوب شيء بسهو الامام ح ٨، ج ٥، ص ٣٤٠.
نقص الركن أو زيادته المبطلين.
ولو نقص سهواً ما يوجب القضاء كالسجدة والتشهّد احتمل وجوبه، خصوصاً السجدة، لأنّه تدارك لنقص الأصل، ولأنّه حقيقةً جزء للصلاة انقلب محلّه الأصليّ الى بعد الصلاة، فتأمّل. واحتمل عدم الوجوب، لأنّ القضاء تكليف جديد، والأصل عدمه، وأدلّة وجوب القضاء(١) قاصرة عن شمول ما نحن فيه، وفيه تأمّل، والأحوط الوجوب.
ولو فعل ما يوجب سجدة السهو لم يجب، للرواية، فتأمل.
ولأنّه يشك (في)(٢) كون الصلاة فريضة واقعاً، لإحتمال الاستحباب.
ولأنّه لا دليل على وجوب سجدتي السهو في كلّ فريضة. ولذا لا يجب في صلاة الكسوف والخسوف، فتأمّل.
الرابعة: لو شك في أنه فعل صلاة الاحتياط الواجب (عليه)(٣) ولم يذهب وهمه الى شيء، والمحلّ باقٍ لعدم حصول ما يوجب الخروج عن محلّه فعله.
ودعوى عدمالوجوب للرواية مدفوعة بما مرّ مراراً، ولو كان بعد الخروج عن محلّه لم يجب، كما لا يخفى.
ولو ذهب وهمه الى أنّه فعله احتمل اعتبار ظنّه، لأنّه حقيقه ظنّ متعلق بعدد ركعات الصلاة، واحتمل العدم، لأنّ ما دلّ على اعتباره مورد الشكّ في حال الصلاة.
(٤) ولو شك في عدد الركعات، وظنّ التمام أخذ بظنه وإن قلنا: إنّه « لا سهو في سهو » بالنسبة الى حكم الظنّ، لأنّه تسهيل، لا تصعيب.
ولو ظنّ النقص أخذ بظنّه إلاّ أن يدّعي نفي السهو للظن، وفيه منع، بل الظاهر
____________________
(١) في « ط ١ »: « الوجوب » وما اثبتناه من « ط ٢ ».
(٢) أثبتناها من « ط ٢ ».
(٣) زيادة من « ط ٢ ».
(٤) في « ط ٢ » زيادة: « ومن هنا » قبل (ولو شكّ).
بقياس الفقرات الاخر خصوص الاحتياط، فتأمّل.
الخامسة: لو شكّ في أنّه حدث فيه سهو عمل بقاعدة الشكّ قبل الفراغ وبعده.
ولو قطع بالغفلة، ثمّ غفل حتى انتقل الى محلّ لا يقبل التدارك جرى عليه حكم استمرار الغفلة.
ولو شكّ قبل الفراغ في الركن وغيره، ثم غفل عن شكّه حتى انتقل الى محلّ لا يقبل التدارك كان ذلك سهواً في غير الركن قطعاً.
وأمّا في الركن: فإن قلنا: إنّ أصالة العدم، وقاعدة الشكّ قبل الفراغ يحرزان العدم أعاد.
وإن قلنا: إنّ الأخذ بالشكّ قبل الفراغ احتياط محض أمكن القول بوجوب الاحتياط بالإتمام والإعادة، للعلم الإجمالي بوجوب أحد الأمرين، والأقوى لعلّه الأوّل، كما أنّ الأحوط الثاني، لكن مع رعاية الجزم الظاهريّ في الإعادة كما يظهر بالتأمّل.
السادسة: لو علم بموجب سجدتي السهو، وشكّ في إتيانهما أتى بهما وإن ظنّ (أنّه أتى بهما)(١) للأصل، وعدم الدليل على اعتبار الظنّ وعموم نفي السهو ممنوع.
ولو شكّ في شيءٍ من واجباته لاحظ بقاء المحلّ وعدمه، ولو سها فيهما بزيادة أو نقيصةٍ، حتى فرغ لم يعتن في الزيادة، لأنّهما لا تزيدان على الصلاة قطعاً، وفي النقيصة داعي بقاء محلّ العود، وعدمه.
فلو قطع بعد رفع الرأس ترك بعض واجباته كالذكر لم يعد، ولو قطع بعد السلام بترك التشهّد احتمل الرجوع وإعادة السلام، واحتمل الاكتفاء بما صنع، لأنّ السجدة قد انقطعت بالسلام.
ولذا يحكم بقضاء التشهّد إن حصل القطع بتركه بعد السلام في أصل الفريضة، ويمكن منع الانقطاع بالسلام مطلقاً، والالتزام بقضاء التشهّد الأخير في
____________________
(١) اثبتنا تلك الزيادة من « ط ٢ ».
الفريضة إن سلّم فللنصّ(١)(٢) ، لا القاعدة، فتأمّل.
ولا يوجبان النقص والزيادة - هنا - سجدتي السهو وإن قلنا بإيجابهما في الصلاة، لأنّ المصغّر لا يصغّر، ولأنّه لا دليل عليه، والأصل البراءة كما لا يخفى.
ولو شكّ في أنّه حصل منه سهو يوجب السجدة فالأصل عدم حصول السبب، والبراءة عن المسبب كما لا يخفى.
ولو شكّ في أنّه شكّ في الصلاة، فإن كان في الصلاة راعى حاله الفعليّ، وإن كان بعد الصلاة: فإن كان فراغه عنها بعنوان أنّه أتمّ عمله واقعاً عمل بقاعدة الشكّ بعد الفراغ بالنسبة الى الركعة المشكوك حصولها، وبأصالة عدم المبطل(٣) بالنسبة الى نفس الشك إن كان مبطلاً.
ولو جهل حاله حين الفراغ بأنّه أتمّ بانياً على الاحتياط، أو أتمّ بانياً على الفراغ واقعاً اشكل التمسّك بقاعدة الشك بعد الفراغ.
إلاّ أن يقال: إنّ فراغه من الصلاة بناء على أنّه أتى بالواقع على ما هو عليه.
وهذا البناء قد يكون بأمر الشارع اذا كان شاكّاً، وقد يكون عقليّاً لعلمه بالتمام، فاذا أحرز الفراغ بهذا العنوان جرى الأصل.
وفيه: أنّ مجرى الشكّ بعد الفراغ هو الشك الحادث بعد العمل، وهو - هنا - مشكوك.
وملخّص الكلام في هذا الباب: ان كلمة (السهو) في قولهعليهالسلام : « لا سهو »(٤) يحتمل إرادة الغفلة الخاصّة، ويحتمل إرادة الشكّ، ويحتمل إرادة الأعمّ. وعلى جميع التقادير، يحتمل إرادة نفسه، ويحتمل إرادة موجبه، فالاحتمالات ستّة.
____________________
(١) في « ط ١ »: « فالنقص » والظاهر تصحيف، وما أثبتناه من « ط ٢ ».
(٢) وسائل الشيعة: ب وجوب قضاء التشهد والسجدة بعد التسليم ح ٢، ج ٥، ص ٣٤١.
(٣) في « ط ١ »: « البطلان » وما في المتن كما في « ط ٢ ».
(٤) وسائل الشيعة: ب عدم وجوب شيء على من سها في سهو ح ٣، ج ٥، ص ٣٤١.
وكلمة (السهو) في قولهعليهالسلام : « في سهو » أيضاً يحتمل الاحتمالات المذكورة، فالخارج - بعد ضرب أحدهما في الآخر - ستّة وثلاثون.
ولكنّ الظاهر من الرواية - قد عرفت - أنّه خصوص الموجب، وخصوص صلاة الاحتياط، والشكّ في قبال الغفلة بالمعنى الأخصّ، وبالمراجعة - فيما ذكرنا - تعرف أحكام الصورة المذكورة، فتأمّل.
مسألة: لا سهو للإمام مع حفظ المأموم، وللمأموم مع حفظ الإمام، لا إشكال في أنّ الشاكّ من الإمام والمأموم يرجع إلى القاطع منهما، وفي رجوع الظانّ الى القاطع إشكال، لأنّ الظاهر من نفي السهو للإمام هو نفي الاحتياط، خصوصاً في مرسلة ابراهيم بن هاشم(١) بقرينة الفقرات الاخر مع وحدة السياق.
وربّما يستظهر من إطلاق رجوع الإمام الى المأمومين في صورة اتّفاقهم بضميمة قول السائل، والإمام مائل مع أحدهما: أنّ الظانّ يرجع الى القاطع.
وفيه : أنّ الرواية في مقام بيان شرائط (رجوع الإمام بملاحظة من يرجع اليه ، و ليس في مقام بيان شرائط)(٢) حتى بالنسبة الى الراجع. ويشهد لذلك قولهعليهالسلام في ذيل الرواية(٣) . فعليهم في الاحتياط الإعادة والجزم، ضرورة أنّه مع اختلاف المأمومين ليس حكم الإمام الاحتياط اذا كان ظانّاً بالتمام أو النقص، فتأمّل جيداً.
هذا كلّه، مضافا الى بعد إيجاب الأخذ بالموهوم، وطرح الظنون.
وهل يرجع كثير الشكّ الى الإمام القاطع بالنقص؟ وجهان: من إطلاق نفي الشكّ لكثير الشكّ، الذي معناه البناء على حصول مشكوك الحصول، إلاّ أن يكون مبطلاً فيبني على عدم حصوله، ومن أنّ موضوع الحكم في كثير الشكّ هو: الكثير
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب عدم وجوب شيء بسهو الامام ح ٨، ج ٥، ص ٣٤٠.
(٢) هذه الزيادة أثبتناها من « ط ٢ ».
(٣) وسائل الشيعة: ب عدم وجوب شيء بسهو الامام ح ٨، ج ٥، ص ٣٤٠.
الشكّ الذي لا طريق له.
ولذا، لو ظنّ النقص وجب له الأخذ بالظنّ، ولعلّ الأخير هو الأقوى.
وهل يرجع الشاكّ فيهما الى الظانّ، أو الى من له الطريق وإن كان غير الظنّ، أو من حكمه ولو بالأصل متعين، أو لا يرجع مطلقاً؟ وجوه: لعلّ الأقوى هو الأخير، إذ لا دليل على شيءٍ من ذلك.
ودعوى أنّ من له الطريق حافظ ممنوعة.
لا يقال: مناط عدم الرجوع الى الإمام أن لا يكون ساهياً، ومن له الطريق لا يعدّ ساهياً.
لأنّا نقول: عدم كونه ساهياً ممنوع، إذ المراد من عدم السهو - هنا - عدم الشكّ وإن حصل له بعد حدوث الشكّ طريق، كما يشهد بذلك قولهعليهالسلام (في)(١) من لم يدر أنّه كم صلى أنّه « أعد إن لم يذهب وهمك الى شيء »(٢) ، مع أنّ (الظاهر من)(٣) الحفظ هو الحفظ التام المساوق للعلم اذا كان بين شكّ الإمام والمأموم رابطة، بمعنى كون أحد طرفي شكهما واحداً واختلفا في الطرف الآخر، كما لو شكّ الإمام بين الثلاث والأربع، والمأموم بين الاثنين والثلاث قيل(٤) : إنّه يرجع كلّ منهما الى الآخر في نفي ما قطع بعدمه، فيرجع الإمام في نفي الأربع الى المأموم والمأموم في نفي الاثنين الى الإمام فيبنيان(٥) على الثلاث.
وربمّا يشكل على ذلك بأنّ أدلّة(٦) رجوع المأموم الى الإمام مقيّدة بعدم سهو
____________________
(١) أثبتناها من « ط ٢ ».
(٢) وسائل الشيعة: ب أنّ من شكّ بين الثلاث والأربع ح ٧، ج ٥، ص ٣٢٢، نقلاً بالمضمون.
(٣) هذه الزيادة من « ط ٢ ».
(٤) الذخيرة: انه لا حكم لشك الامام والمأموم مع حفظ الاخر ص ٣٦٩، س ٣٩.
(٥) في « ط ١ »: « فيتبانا » وهو تصحيف والصحيح ما أثبتناه.
(٦) في « ط ١ »: « بأدلة » وما هو مثبت في المتن موافق للسياق.
الإمام وحفظه، ولا ريب أنّه في(١) مثل الفرض غير حافظ.ودعوى أنّه حافظ بالنسبة الى ما قطع به وإن لم يكن حافظاً بالنسبة (الى)(٢) ما شكّ فيه مدفوعة بأنّ المنساق في الأدلّة غير ذلك ، و أيضاً لا وجه لتقييد الرجوع بوجود الرابطة ، إذ مع فرض عدم الرابطة (قد)(٣) يوجد لكلّ منهما قطع بخلاف ما يحتمله الآخر، فيجب الرجوع اليه، فأنّ المأموم إن شكّ بين الواحد والاثنين، والإمام بين الثلاث والأربع يكون المأموم قاطعاً(٤) بنفي الرابعة، والإمام بحصول الثالثة، ولا يجوز الرجوع في المثال الى المأموم في نفي الثانية(٥) كما لا يخفى.
إلاّ أن يقال: إنّ التقييد بالرابطة لأجل أنّه مع عدم الرابطة لا يمكن بقاء القدوة(٦) ، فيبطل موضوع الإمامة والمأموميّة، الذي هو مناط رجوع أحدهما الى الآخر.
ويشكل عليه: بأنّه ما لم يحصل من أحدهما ما يوجب فساد عمله لا يحكم بفساد صلاته ولا تبطل القدوة(٧) ، بل الظاهر جواز بقاء كلّ منهما على القدوة، والعمل عليه ما لم يصدر من الإمام ما يوجب حكم المأموم بفساد صلاته.
ومن ذلك يعلم: أنّه إن قلنا بعدم الرجوع، مع وجود الرابطة، وكان الفرض صحة صلاتهما جاز البقاء على القدوة(٨) ، كما لو فرض أنّه شكّ الامام بين الاثنين والثلاث قبل الإكمال، وظن الثلاث، والمأموم بين الثلاث والأربع قبل الإكمال جاز للمأموم الاقتداء في ما بقي من الركعة التي حكم الإمام عليها بأنّها ثالثة،
____________________
(١) في « ط ١ »: « في أنّه » وما أثبتناه أوفق للتعبير.
(٢) و (٣) أضفناهما من « خ ٢ » لضرورتهما.
(٤) في « ط ١ » « قطعاً » وهو تصحيف وما مثّبت هو الصحيح.
(٥) في « ط ١ »: « الثالثة ظ » والظاهر ما أثبتناه وكما في « ط ٢ ».
(٦) و (٧) و (٨) في « ط ١ » « القدرة » والظاهر أنّها بعيدة لما مقصود، ومن النظر للمعنى يظهر أن القدوة بمعنى الاقتداء هي الأنسب ومجالها هنا للإمام في الصلاة ولذا أثبتناها، فهي الأصحّ بعكس الاخرى التي لا معنى لوجودها.
والمأموم يحكم عليها بأنّها رابعة، لأنّها صحيحة واقعاً من الإمام.
ولذا، لو انقلب شكّه بعد انتهاء تلك الركعة الى ما يعتقده المأموم صحّت صلاته قطعاً، وأمّا مع الرجوع، مع وجود الرابطة فبقاؤه(١) لا إشكال فيه، بل الظاهر جواز الاقتداء اذا كانا شاكّين بشكّ(٢) واحدٍ إلاّ في صلاة الاحتياط، لاحتمال أن يكون نافلةً على إشكال فيه، لأنّها فعلاً واجبة.
ومن هنا ينقدح، أنّه لو علم المأموم حاجة الإمام الى الركعة التي بنى على الاحتياط فيها، ولم يرجع الى المأموم لأجل مانع من الرجوع جاز له الاقتداء بتلك الركعة، لأنّها صحيحة واقعاً، مثلاً: لو شك الإمام بين الثلاث والأربع، والمأموم قاطع بالثلاث، ولم يتمكّن من إفهام الإمام أنّها ثالثة، فبنى الإمام على الأربع، وأتى بركعة الاحتياط جاز للمأموم أن يبقى على القدوة(٣) ، الى أن تنتهي صلاة الاحتياط.
نعم، إن قلنا: إنّ صلاة الاحتياط مستقلة حتى على تقدير الحاجة، ويكون تداركاً لما فات أمكن منع القدوة(٤) فيها، بناءاً على أنّه لا يجوز الاقتداء في فرض واحد بفرضين كصلاة ظهر الحاضر بظهريّ المسافر، فتأمل في ذلك(٥) .
مسألة: إن زاد ركوعها فالظاهر بطلان الصلاة، والظاهر أنّه لا خلاف فيه، كما حكاه بعض(٦) ، واستدلّ له مضافاً الى ذلك بقولهعليهالسلام : « من استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها، واستقبل صلاته استقبالاً »(٧) .
وبقولهعليهالسلام : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة »(٨) .
____________________
(١) في « ط ١ »: « قضاه » وهي تصحيف والأظهر ما مثبّت كما في « ط ٢ ».
(٢) في « ط ١ »: « مثل » وهي ركيكة في المعنى وما أثبتناه أنسب لحسن السياق.
(٣) و (٤) راجع الهامش(٣ و ٤ و ٥) من ص ٤٣٢.
(٥) الى هنا انتهى ما كان مدوّناً في « ط ٢ » والمقابل مع المستنسخ الخطّي.
(٦) الرياض: في الخلل الواقع في الصلاة ج ١، ص ٢١٢، س ١٥.
(٧) و (٨) وسائل الشيعة: ب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعداً ح ١، ٢ ، ج ٥، ص ٣٣٢.
وبقولهعليهالسلام فيمن زاد سجدةً: « لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة »(١) بناءاً على أنّ المراد من الركعة بقرينة مقابلتها للسجدة الركوع، وبأنّ في زيادة الركوع تغييراً لهيئة الصلاة، وخروجاً عن الترتيب الموظّف.
ويمكن المناقشة في الأخير: بأنّ الترتيب الموظّف لم يعلم عدم كون زيادة الركوع فيه، حتى في حال السهو، وفي الروايتين الاوّلتين، مضافاً بأنّه لا دلالة في مقابلة الركعة بالسجدة أنّ المراد منها الركوع.
أمّا في الثانية: فبأنّ عموم « لا تعاد »(٢) حاكمة عليها، ودعوى إجمالها بالنسبة الى زيادة الركوع قد عرفت الكلام فيه.
وأمّا الاولى وإن كانت أخصّ من « لا تعاد » لاختصاصها بقرينة قولهعليهالسلام : « من استيقن»(٣) بصورة السهو، إلاّ أنّ في دلالتها على الإعادة بزيادة الركوع منعاً.
وتوضيح المقام: أنّ المزيد، والمزيد عليه لابدّ وأن يكونا من سنخ واحد، وإلاّ لم تصدق الزيادة.
لا يقال: زيد في منى(٤) أو في العمرة أو في الطواف إلاّ باعتبار إضافة مقدار من سنخه عليه.
وحينئذٍ، فإن كان المزيد عليه هي الصلاة لم تصدق الزيادة عليها، إلاّ بإضافة ركعة زائدة اليها.
وإن كانت ذوات الأجزاء لم يصدق إلاّ بإضافة فردٍ آخر زائدٍ على ما اعتبر في الصلاة عليها.
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب بطلان الصلاة بزيادة ركوع ولو سهواً ح ٣، ج ٤، ص ٩٣٨.
(٢) وسائل الشيعة: ب عدم وجوب الاعادة على من نسى القراءة ح ٥، ج ٤، ص ٧٧٠.
(٣) وسائل الشيعة: ب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعداً ح ١، ج ٥، ص ٣٣٢.
(٤) في نسخة الأصل « المناء » وهي تصحيف.
وإن كان مفهوم الجزء بهذا العنوان لم يصدق إلاّ بإضافة شيءٍ ولو من غير نوع أجزائها عليها بعنوان الجزئية، والدخول في المركّب كما يقال: (إذن(١) الطبيب في المعجون الفلاني جزء)، وفي مصطلح أهل التصريف: (الفعل مزيد فيه).
ولا ريب أنّ المعنى الثاني بملاحظة الصلاة أعمّ من الأول، لشمول الثاني لزيادة الركعة من حيث كون الركعات المعتبرة في الصلاة زيد عليها ركعة لزيادة الركوع بخلاف الأوّل، فأنّه لا يشمل إلاّ زيادة الركعة، من حيث أنّها صلاة زيدت على الصلاة، كما أنّ الشوط باعتبار أنّه طواف يعتبر زيادة على الطواف، والمعنى الثالث أعمّ من الثاني كما يظهر بالتأمل.
وحينئذٍ نقول: لم يظهر من الرواية(٢) الشريفة أنّ المزيد عليه اعتبر أيّ شيء، بل ربّما يمكن من دعوى ظهورها بالقياس الى الأمثلة التي ذكرناها في زيادة الصلاة على الصلاة، فلا يشمل زيادة الركوع، فلم يبق في المسألة إلاّ نفي الخلاف، وهو فيمن تذكّر بعد استقراره راكعاً، قبل أن يرفع رأسه ممنوع.
فقد حكي عن الكافي(٣) والشيخ(٤) والمرتضى(٥) وابن إدريس(٦) (أنّه يرسل نفسه ساجداً).
وحكي تقويته من الذكرى(٧) . وقواه في المدارك(٨) قال: (وهذه الزيادة لم تقتض تغيّراً لهيئة الصلاة، ولا خروجاً عن الترتيب الموظّف، فلا تكون مبطلة،
____________________
(١) في الأصل « اذا » وهي ركيكة وبعيدة في المعنى وما أثبتناه هو الأصحّ.
(٢) وسائل الشيعة: ب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعداً ح ١، ج ٥، ص ٣٣٢.
(٣) الكافي: باب تفصيل احكام الصلاة الخمس ص ١١٨.
(٤) النهاية: باب السهو في الصلاة ص ٩٢.
(٥) رسائل الشريف المرتضى: فصل في احكام السهو ج ٣، ص ٣٦.
(٦) السرائر: في احكام الشك ج ١، ص ٢٥١.
(٧) الذكرى: القول في الشكّيات ص ٢٢٢، س ٢٣.
(٨) مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج ٤، ص ٢٢٤.
لانتفاء ما يدلّ على بطلان الصلاة بزيادته على هذا الوجه من نص أو إجماع) وهذا الكلام منه -رحمهالله - راجع الى دعوى انصراف الأدلّة، وإلاّ فقد تمسّك هو بالأدلّة السابقة على البطلان بزيادة الركوع من غير مناقشةٍ له فيها، وهي ممنوعة جدّاً.
نعم، إن قلنا: إنّ رفع الرأس داخل في مقدّم الركوع أمكن منع تحقّق زيادة الركوع، ولكنّه واضح المنع، كما أنّه يمكن دفع ما ذكرنا من المناقشة بإمكان أن يكون المراد من الرواية(١) حصول الزيادة في أثناء الصلاة، من غير نظرٍ الى المزيد عليه، فتكون شاملةً للاعتبارات الثلاثة، وفيه نظر.
نعم، حكي عن التنقيح(٢) دعوى الإجماع على أنّ زيادة الأركان مبطلة، ولا يبعد الركون اليه بعد مساعدة المشهور وندرة المخالف، فالقول بالبطلان مطلقاً أقوى، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة كما لا يخفى.
وممّا يوهن التمسّك بالرواية(٣) أنّ زيادة غير الأركان، حتى السجدة الواحدة خارجة عنها بالإجماع، والرواية - كما عرفت - وفي حملها على خصوص الأركان لم يعلم أولويّته من الحمل على زيادة نفس الصلاة، فيكون نظير قولهم: (زاد اللّه في عمرك).
ودعوى أنّ استعمال (في) بمعنى (على) مجاز، لا يصار اليه إلاّ بقرينة، مدفوعة بمنع استلزام ذلك المعنى كون (في) بمعنى (على)، فتأمّل.
مسألة: لو نقص من صلاته ركعة حتى سلّم، فهل يحكم بالبطلان، لأنّ السلام قد فصل بين الركعة الناقصة، وما سبق عليها فيحقّق موضوع النقص به؟ لا إشكال(٤) في بطلان الصلاة بنقص ركعةٍ لأنّها ركن وزائد.
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعداً ح ١، ج ٥، ص ٣٣٢.
(٢) التنقيح: في احكام الخلل ج ١، ص ٢٦٠، وجاء فيه وعليه الفتوى بدل الاجماع.
(٣) وسائل الشيعة: ب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعداً ح ١، ج ٥، ص ٣٣٢.
(٤) في نسخة الأصل: « والإشكال » والظاهر تصحيف لأنّ « لا إشكال » جواب السؤال الوارد في السطر السابق ولذا فقد أثبتناه في المتن.
ويشهد لذلك ما دلّ على أنّ من نسي سجدةً قضاها بعد السلام، ولو لم يكن السلام فاصلاً وجب أداء السجدة، وإعادة ما لحقها من التشهّد والتسليم، كمن تذكّر نسيان السجدة في أثناء الصلاة أو بعدها قبل التسليم.
ويرد عليه: أن كون السلام سيّما في غير محلّه فاصلاً محلّ منع. وهل هو إلاّ من كلام الآدميين.
وأمّا مسألة السجدة، فمع إمكان منع الحكم فيها - كما ذكر - فيما يشبه الفرض يرد عليه أنّه لم يعلم كونه قضاءاً، ولم لا يكون من باب سقوط الترتيب بين الأجزاء، بل الظاهر من بعض روايات تلك المسألة ذلك، فليراجع مع أنّ كون السلام فاصلاً بالنسبة اليها لا يقتضي كونه كذلك بالنسبة الى الركعة، فالأولى أن يقال: مقتضى القاعدة صحة الصلاة ما لم يحصل قاطع يعمّ حالتي العمد والنسيان، لأنّ زيادة التشهد والتسليم لا حكم لهما، وأما السكوت نقص في الأصل.
مسألة: لو علم قبل السلام المخرج ترك ركعة تامة أو سجدتين من الركعة الأخيرة، أو سجدة واحدة منهما فالظاهر وجوب الإتيان بما تركه قطعاً وإعادة ما أتى به من التشهد، ويحكم بما أتى به سابقاً أنّه زيادة سهوية، والظاهر أنّه لا إشكال فيه، ولو علم بها بعد السلام فكذلك اذا لم يقع منه ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً.
ودعوى أنّ السلام مخرج ويلزمه بطلان الصلاة بترك السجدتين، ووجوب قضاء السجدة الواحدة، مدفوعة بأنّ السلام إن وقع عمداً مخرج وليس له إلاّ حكم كلام الآدميين، كما يدلّ عليه التعليل بجعله مخرجاً في علل(١) الفضل بأنّه من كلام الآدميين.
وقد يقال بالصحة - كما ذكرنا - إلاّ أنّه يحكم في صورة ترك السجدة بوجوب قضائها، لا الإتيان بها وإعادة التشهّد والسلام. ولا يخفى ما فيه من الإشكال، فأنّه يجب الإتيان بالسجدة أداءً، والحكم على السلام بكونه غير مخرجٍ من حيث كونه
____________________
(١) عيون أخبار الرضا: باب فيه علل بعض الاحكام ج ٢، ص ١٠٧.
كلاماً سهويّاً، فأنّ الظاهر عدم الإشكال في وجوب الإتيان بالسجدة وإعادة التشهّد، وإجراء حكم السهو على الكلام المذكور، إلاّ أن يدّعى أن الفارق هو النصّ.
قال محمد بن مسلم في الصحيح في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، فقال: إن كان قريباً رجع الى مكانه، فتشهّد(١) .
وفي قرب الاسناد، بسنده عن عليّ بن جعفرعليهالسلام قال: سألتهعليهالسلام عن رجلٍ سها وهو في السجدة الأخيرة من الفريضة، قال: « يسلّم ثم يسجد »(٢) .
هذا، ولكنّ دلالة الاولى مع ابتنائها على شمولها لما إذا لم يصدر منه ما يكون قاطعاً، عمداً وسهواً موقوفة على عدم القول بالفرق بين التشهّد والسجدة.
ودلالة الثانية مبنيّة على أنّ المراد من كونه في السجدة الأخيرة كونه في محلّها بقرينة الأمر بالسجود بعد التسليم، وأنّ المراد من التسليم هو المستحبّ بعد تحقّق الانصراف بالتسليم الواجب.
(تمّت): هذا آخر ما برز من تحرير سيّدنا العلاّمة أية اللّه السيّد محمّد الأصفهاني -قدسسره - في بحث الخلل مجتمعاً، ووجد بعض أوراقٍ متفرّقة بخطّه الشريف، غير مبيّضةٍ ولا مهذّبةٍ، فاستنسخته أيضاً لما فيه من الفائدة الكثيرة للطلاب.
مسألة: لو شكّ في شكّه في الصلاة رجع الى حكم الشكّ المتولّد من هذا الشكّ، فلو شكّ في أنّه كان شكّه بين الاثنين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع عمل عمل الشكّ بين الاثنين والثلاث والأربع، وهكذا لو شكّ بين الاثنين والثلاث، وبنى على الثلاث، ثم شكّ في أنّه أتى بالرابعة أم لا، رجع شكّه الى
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهد ح ٢، ج ٤، ص ٩٩٥.
(٢) قرب الاسناد: ص ٩٢، س ١.
الشكّ بين الاثنين والثلاث والأربع، وعمل عمله.
ولو شكّ بعد الصلاة أنّ الاحتياط الذي عليه ركعتان من قيام أو ركعة من قيام، فإن قلنا: إنّ الفصل مطلقاً غير مضرّ احتاط بالجمع بينهما، وإن قلنا: إنّه مضرّ احتمل الجمع بينهما - أيضاً - بإجراء أصالة عدم تحقّق الفصل.
ويرد عليه: أنّه يقطع في الفصل الثاني تحقّق الفصل بينه وبين الصلاة، وحينئذٍ تجب عليه إعادة الصلاة تحصيلاً للبراءة القطعيّة.
إلاّ أن يقال: إنّ الفصل بصلاة الاحتياط غير مضرّ، لاستفادة ذلك من صور الشكّ المنصوصة كالشك بين الاثنين والثلاث والأربع، فتأمل.
ولو سها بعد الصلاة بما يبطل الاحتياط، عمداً وسهواً أعاد الصلاة، ولو أتى بما يوجب سجدتي السهو في صلاة الاحتياط فالأصل عدم وجوبه، لأنّه لا يعلم أنّها صلاة يوميّة، لجواز أن يكون مستحبّاً واقعاً.
هذا إن قلنا: إنّ كلّ ما كان منالصلاة اليومية فيه سجدة السهو، وإن قلنا ذلك، وقلنا: إنّها صلاة مستقلّة فالأمر أوضح.
ولو التفت بعد الصلاة لحاجته الى صلاة الاحتياط، ووقع منه ما تجب عليه فيه سجدتا السهو وجبت - حينئذٍ - على الأوّل، ومنعناه على الثاني، مضافا الى احتمال عموم « لا سهو في سهو »(١) فتأمّل.
الشكوك الغير منصوصة: إمّا مركّبة من الشكوك الصحيحة كالاثنين والأربع والخمس، والحكم فيها - حينئذٍ: إمّا البناء على الأكثر الصحيح، وعمل الاحتياط لقولهعليهالسلام : « ومن شكّ في الأخيرتين عمل بالوهم »(٢) والبناء الزائد المحتمل على العدم، وسجدتي السهو: إمّا لقولهعليهالسلام : « أم زدت أم نقصت »(٣) بناءاً على أنّ المراد منه غير الإجمال، وغير خصوص الزيادة المحتملة
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب عدم وجوب شيء على من سهى في سهو ح ٢، و٣، ج ٥، ص ٣٤١.
(٢) وسائل الشيعة: ب بطلان الصلاة بالشك في عدد الاولتين ح ١، ج ٥، ص ٢٩٩.
(٣) وسائل الشيعة: ب ان من شك بين الاربع والخمس فصاعداً ح ٤، ج ٥، ص ٣٢٧.
وقولهعليهالسلام : « اذا لم تدر أنّك زدت، أم نقصت فاسجد سجدتي السهو »(١) .
وإمّا لتنقيح المناط من الأدلّة الدالّة على أنّ « الشاكّ(٢) بين الأربع والخمس يسجد سجدتي السهو ».
وإمّا لأنّها شاملة لهذا المورد، وإمّا لأنّ احتمال الزيادة المضرّة الحاصلة، مدفوع بالأصل، ولا دليل على سقوط الأصل وهذا المورد.
وإمّا مرّكبة من [ الشكوك ](٣) الصحيحة وغير الصحيحة، المنصوصة وغير المنصوصة، التي حكمها البطلان، كالشكّ بين الاثنين والأربع والخمس بعد الركوع أو قبله، وهذا حكمه ظاهريّ، لأنّ الشكّ في الاوّلتين حكمه البطلان.
وأمّا من الشكوك المنصوصة وغير المنصوصة: كالشكّ بين الثلاث والأربع والخمس بعد الركوع، قبل إكمال السجدتين، والحكم فيه من حيث الثلاث والأربع هو البناء على الأربع والاحتياط.
وأمّا من حيث الأربع والخمس فتحتاج الى الدليل، والأصل ساقط، فيجب الحكم بالبطلان.
نعم، إن قلنا: إنّ الأصل غير ساقطٍ في الشكّ بين الأربع والخمس بعد الركوع، قبل إكمال السجدتين ظاهر الأمر هنا كذلك.
أو قلنا: إنّ ما دلّ على أنّ الشكّ بين الأربع والخمس يشمل الشكّ قبل إكمال السجدتين فتجري فيه الوجوه المتقدّمة.
وأمّا بسيطة غير منصوصةٍ، والشكّ في الزيادة انصرافه كالشكّ بين الأربع والستّ، والصحة هنا محتملة بناءً على بعض الوجوه المتقدّمة في الشكّ بين الاثنين
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب أن من شكّ بين الأربع والخمس ح ٤، ج ٥، ص ٣٢٧، مع اختلاف يسير.
(٢) في الأصل: « الشك » وهو تصحيف وما أثبتناه هو الأصح.
(٣) أضفناها استحساناً لمجرى السياق.
والأربع والخمس، ويحتمل البطلان بناءاً على ما مرّ من سقوط الأصل وانتفاء، العلاج.
وأمّا بسيطة غير منصوصةٍ ويحتمل فيه النقص والزيادة كالشك بين الثلاث والخمس، والحكم هنا البطلان، لأنّ الصحة هنا طريقه منحصر في البناء على الأقل بإجراء أصالة عدم الزيادة.
والظاهر أنّ هذا خارج عن طريقة الأصحاب، فاختلف الأصحاب في جواز الصلاة مع المحمول النجس، احتجّ القائلون بالمنع بأن كلمة « لا تصل في النجس » ظاهر في مصطلح الأخبار في الصلاة مع النجس، من غير فرق بين اللباس والمحمول.
وربّما روي عن عليّ بن جعفرعليهالسلام ، عن أخيه موسىعليهالسلام من الصلاة في جلد حمار، فقالعليهالسلام : « لا يصلح »(١) وفي دلالته نظر؛ إذ لا شاهد على كون الجلد من الحمار الميت إلا ندرة ذبح الحمار.
وظهور النهي في الحرمة، وحملة على الكراهة غير بعيدٍ بقرينة ترخيص الصلاة مع خوف ذهابه.
إلاّ أن يقال: خوف الذهاب عذر، وإطلاق الترخيص شاهد بجواز البداء، والاولى الاعذار وهو بعيد.
ولمكاتبة عبد اللّه بن جعفر، عن أبي محمدعليهالسلام ، قال: كتبت اليه عن الصلاة في فأرة مسكٍ فكتب: « لا بأس اذا كان ذكيّاً »(٢) والاستدلال مبنيّ على عدم الفرق بين الميتة وغيره، وفيه منع، أو يراد من الذكي الطاهر وفيه - أيضاً - منع لاحتمال أن يكون بالذال المعجمة، المراد به ما يقابل الميتة كما لا يخفى (تمّت) والحمد للّه رب العالمين، استنسخه العبد المسمّى هادي بن عباس بن محمد - غفر
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب ٦٠ من أبواب لباس المصلي ح ٢، ج ٣، ص ٣٣٧ نقلاً بالمضمون.
(٢) وسائل الشيعة: ب ٤١ من أبواب لباس المصلي، ح ٢، ج ٣، ص ٣١٥.
اللّه ولوالديه - وفرغت منه يوم ثمان وعشرين من شهر شوّال المكرّم، من سنة ألفٍ وثلاثمائة وثلاثة وخمسين، في مشهد أبي الأئمة على مشرّفه آلاف التحيّة والسلام، والحمد للّه ربّ العالمين، والصلاة على سيّدنا محمدٍ وآله الطاهرين. استنسخته من نسخة الشيخ، العالم الجليل، الشيخ آقا بزرك الطهراني أصلاً والساكن بالعسكرين، الذي استنسخته من نسخة مولانا وملاذنا، الشيخ عبد الكريم اليزديّ، الذي [ هو ](١) تلميذ المصنّف، وهو السيّد الأجلّ العلاّمة السيّد محمد الأصفهاني المتوفّى في سنة ١٣١٦. ولقد وقع الفراغ عن استنساخ هذه الرسالة الشريفة عن خط مصنّفها، العلاّمة المحقّق الفشاركي -قدسسره - في صباح الجمعة.
بيد العبد المذنب الجاني، محمد مهدي بن حسين بن أحمد شب زنده دار، غفر اللّه تعالى لنا ولجميع علمائنا الماضين، لاسيّما المؤلف العلاّمة، وتلميذه المؤسّس الشيخ عبد الكريم الحائري -قدسسره ما -.
وأسأل اللّه تعالى أن يتقبّل ما تفضّل به علينا شيخنا الاستاذ العلامة المحقق الشيخ مرتضى الحائريّ.
____________________
(١) أضفناها لتقوية الكلام.
رسالة في الخيارات
بسم اللّه الرحمن الرحيم
وبه نستعين
الحمد للّه رب العالمين، وصلّى اللّه على سيدنا محمد وعترته الطاهرين، والعن أعداءهم الى يوم الدين.
القول في الخيارات
ومفرده الخيار، وهو في اللغة إسم للاختيار كما في الصحاح(١) ، وهو الترجيح وطلب الخير. وقد يطلق على القدرة على ذلك، ومنه المختار إذا قوبل بالمضطرّ.
وفي الاصطلاح، فقد يعرّف بأنّه: ملك فسخ العقد(٢) ، ويدخل فيه رّد بيع الفضولي، والرجوع في العقود الجائزة كالهبة، وردّ الوارث عقد الميّت بالنسبة الى الزائد عن الثلث، وردّ العمّة والخالة نكاح بنت الأخ والأخت.
وقد يعرّف بأنّه: ملك إقرار العقد وإزالته(٣) .
ويرد عليه أنّه: إن اريد من الإقرار إبقاؤه وترك فسخه فذكره مستدرك، لأنّ
____________________
(١) الصحاح ٢ / ٦٥١ (خير) وفيه: والخيار الإسم من الاختيار.
(٢) المكاسب: الخيارات ص ٢١٤.
(٣) المكاسب: الخيارات ص ٢١٤.
القدرة على أحد الطرفين من الوجود والعدم، من دونها على الآخر غير معقول.
وإن اريد إحكامه وإثباته فلا تعرف تزلزلاً للعقد إلاّ كونه متعلّقاً للخيار فإحكامه ليس إلاّ إزالة ذلك، وهي إسقاط الخيار.
ولا ريب أنّ دخول إسقاط الخيار في مفهومه غير معقول، فلا ينبغي أخذه في تعريفه.
وتوضيح ذلك: أنّ تأثير العقد مع الخيار وبدونه غير مختلف لأنّ أثره ليس إلاّ تحقّق الملكية، وليس للملك قسمان حتى يقال: إنّ إزالة العقد رفع الملك، وإقراره جعل المتزلزل من الملك لازماً، وإنّما التزلزل من أوصاف العقد، ومرجعه الى كونه مورداً لحقّ الخيار لأنّه أمر منتزع منه، فإقرار العقد، وإضافة وصف التزلزل منه ليس إلاّ إسقاط منشأ انتزاعه. ثم إنّ: الظاهر أنّ الخيار من الحقوق؛ لوجود لوازمه فيه من سقوطه بالإسقاط، وتوريثه.
والفرق بين الحقّ والحكم: أنّ الحكم ليس إلاّ أمراً اعتبارياً، منتزعاً من حكم الشارع كالسلطنة على إسترجاع العين الموهوبة؛ فانّها ليست إلاّ معنىً منتزعاً، وجواز الرجوع ونفوذه.
والحقّ عبارة عن أمر تتعلّق به الملكية كالأعيان الخارجية، ومن حكمه إسقاطه وانتقاله إلى الغير قهراً أو اختياراً كحقّ المضاجعة، فأنّه قابل للانتقال من إحدى المضرّتين الى الاخرى. وليس هذه الخواصّ مساويةً له في الوجود؛ إذ من الحقوق ما لا يقبل النقل الاختياري كخيار المجلس والحيوان - مثلاً - فعدم بعضها لا يدلّ على عدم حقّاً، وهل عدم الجميع كاشف عن ذلك أو لا؟
الظاهر ذلك، وسيأتي بيانه - إن شاء اللّه تعالى - فيبين أنّ ردّ السلطنة على الردّ في بيع الفضولي، وعلى الرجوع في العقود الجائزة ليست من الخيار.
والظاهر خروجهما عن الحدّين - أيضاً - لما في لفظ الملك من البيّنة على ذلك. فأنّ الفضولي ليس مالكاً للردّ، وإنّما تكون مالكيته للعين نفوذ تصرفاته التي منها الردّ فيها.
ويمكن المناقشة في ذلك: بأنّ الفسخ أيضاً ليس ملكاً لذوي الخيار، فإن اريد من ملك الفسخ السلطنة عليه فخروج الرّد لا وجه له.
وإن اريد من « ملك » هو الفسخ لتكون الإضافة بيانيّة كقولهم: عقد البيع؛ صحّ الإخراج، إلاّ أنّه فاسد لما مرّ من عدم كون الفسخ ملكاً، مضافاً الى أنّه ليس هو الفسخ.
ويمكن إخراجه: بأنّ الردّ ليس رفعاً لأمر واقع؛ بل هو رفع لماله قابلية الوقوع.
والحاصل: إنّ الفسخ رفع، والردّ دفع.
مقدمة
المحكّي عن العلاّمة: أنّ الأصل في البيع اللزوم(١) ، وتبعه جماعة - كما قيل - بل شاع ذلك في لسان المحصّلين، حتى كأنّه من المسلّمات، وهو يحتمل وجوهاً:
أحدها: القاعدة، فالمعنى أنّ القاعدة المستفادة من العمومات لزوم البيع، وهي كثيرة.
منها: قوله تعالى: (أحلّ اللّه البيع)(٢) دلّ على أنّ التصرّفات المترتّبة على البيع حتى الواقعة منها بعد الفسخ حلال، وحلّيّتها لازم مساوٍ للملكيّة، وعدم تأثير الفسخ.
ويمكن المناقشة: بأنّ معنى الآية ليس حلّ جميع أشخاص التصرّفات التي يتصوّر وقوعها بعد البيع، بل معناها - واللّه العالم - أنّ التوصّل بالبيع إلى ما هو المقصود منه، وهو السلطنة على المال، والتقلّب فيه بأيّ نحو ارادة البائع - مثلاً - حلال، وحلّيّة هذا المعنى يدلّ عرفاً على أنّ المقصود من البيع حاصل ومترتّب عليه. وأمّا أنّ تلك السلطنة باقية لا تزول، فيردّهم الفسخ. فليس أمراً مربوطاً بمدلول الآية، وليس فيها جهة
____________________
(١) تذكرة الفقهاء: في الخيارات ج ١ ص ٥١٥ س ٢٩. وراجع مفتاح الكرامة: ج ٤ ص ٥٣٧.
(٢) البقرة: ٢٧٥.
تقتضي الإطلاق من تلك الجهة.
ومنها: قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارة عن تراض)(١) ، والاستدلال تارةً بالمستثنى منه، واخرى بالمستثنى.
أمّا الأوّل: فلدلالته على أنّ الأكل بكلّ وجهٍ يكون باطلاً عند العرف حرام. وتملّك مال الغير بأيّ سببٍ كان من غير رضاه باطل عرفاً، فالأكل المستند إليه أكل بالباطل، ويحرم بمقتضى الآية. فشمول الآية له مشكوك، ولكنّ الاستدلال بالآية ينفع عند القطع بكون الفسخ عرفاً باطلاً. وأمّا مع الشك في ذلك فكيف يصحّ التمسك بها لعدم تأثيره ؟.
مضافاً إلى إمكان أن يقال: إنّ المراد من الباطل هو معناه في نفس الأمر، وفهم العرف طريق الى تشخيص مصاديقه. ولهذا: نقول في الموارد التي ثبت من الشرع جواز الأكل بالباطل عرفاً: إنّ ذلك دليل على خطأ العرف في الحكم بالبطلان، لأنّه اختصّ حكم الآية بغير تلك الموارد - وحينئذٍ - فمورد الشك في إذن الشارع في الفسخ يكون اندراجه في الباطل مشكوكاً، وإن فرضنا أنّه مندرج فيه عند العرف، لاحتمال أن يكون حكم العرف في الواقع خطأً فلا تنفع الآية في نفع تأثيره - حينئذٍ - أيضاً
هذا كلّه مع إمكان أن يقال: إنّ الباطل ليس إلاّ ما لم يأذن فيه الشارع، وإشكال التمسّك بها - حينئذٍ - أقوى؛ إذ لا طريق الى تشخيص الباطل في مورد الشكّ مطلقاً، ضرورة أنّ العرف لا تدخّل له في تشخيص موارد حصول الإذن، ولكنّ الإنصاف أنّ هذا خلاف المتبادر من الآية.
هذا إن اريد استعمال كلمة « الباطل » في المفهوم المذكور، وإن اريد أنّه استعمل في معناه اللغوي، وهو الفاسد - ولكنّ إذن الشارع، وعدمه ميزان لتشخيص مصاديقه - لزم خلوّ هذا الخطاب عن الفائدة؛ لأنّ عدم إذن الشارع فيه حيث علم
____________________
(١) النساء: ٢٩.
به كفى في المنع، وحيث جهل لم يكن في الآية دلالة على حكمه.
والتحقيق أن يقال: إنّ المراد: هو المفهوم اللغويّ، والمميّز هو العرف. والسرّ في ذلك أنّ الشارع في مخاطباته جارٍ على سلك العرف، ومنزّل نفسه منزلة أحدهم، ولازم ذلك إذا كان موضوع حكمه من الامور التي تحقّقها منوط باعتبار المعتبرين، وحكم الحكام، وكان للعرف اعتبار وحكم، فالمناط تدركه عقولهم بحيث متى تحقّق ذلك الاعتبار، والحكم في مورد كان ذلك الموضوع الذي حمل الشارع عليه الحكم محقّقاً عندهم أن يكون مراد من خطابه الحكم على تلك المصاديق التي بيد العرف، أو يبيّن أنّ الملاك في تشخيص مصاديق ذلك الموضوع غير تأييد العرف.
وحيث كان البطلان من الاعتبارات اللاحقة للأسباب - بملاحظة أهل الاعتبار - كان جعله مناطاً للأسباب المحلّلة للأكل، والمحرّمة له، من غير بيان ميزان لتشخيص موارد تحقّقه دليلاً على إمضاء حكم العرف.
فاتّضح من ذلك: صحّة التمسّك بالآية في الموارد المعلوم كون سبب الأكل فيها باطلاً عرفاً، وإن لم يعلم حكم الشارع في ذلك السبب مع قطع النظر عن الآية، فتأمّل.
وتصحيح التمسّك بالآية فيما لم يعلم حكم الشارع فيه من الأسباب بأن مستنداً الى ما لم يعلم كونه مسبباً لحلّة أكله بالباطل لا يخلو من الضعف، لأنّ صدق ذلك - مع قطع النظر عن أصالة عدم التأثير - محلّ منع؛ ومعها لم يحتج الى التمسّك بالآية، إذ لا تزيد على ما يقتضيه الأصل من الحكم الظاهري.
وأمّا الثاني: فلدلالته على أنّ جميع التصرّفات المترتّبة على التجارة عن تراض جائز، ولا وجه عدم تأثير الفسخ.
وفيه: أن المستفاد فيه ليس إلاّ أنّ الأكل بواسطة التجارة حلال، وأنّها سبب لحصول النقل والانتقال، وأمّا أنّ هذا الحكم يدوم، وهذا السبب لا يزيل أثره مزيل فلا يستفاد منه.
ومنها: قوله تعالى: (أوفوا بالعقود)(١) وتقريب الاستدلال: أنّ العقد هو العهد، والوفاء ترتيب آثار مقتضاه عليه، فاذا وجب ذلك حتى بعد الفسخ لزمه عدم تأثيره في زوال أثر العقد، فالعقد الذي يقتضي ملكية شيء اذا وجب على العاقد ترتيب أثر الملكية الذي هو عدم التصرف في ذلك المال بغير إذن من له المال حتى بعد الفسخ، كان ذلك دليلاً على عدم تأثير الفسخ في رفع مقتضى العقد.
ويمكن المناقشة في ذلك: بأنّ وجوب الوفاء بالعقد تابع لبقاء العقد، فاذا شككنا في أنّ الفسخ رفعه أم لا لم يمكن في الآية دلالة على وجوب الوفاء به بعد الفسخ، ليلزم منه عدم تأثيره في رفع العقد.
وتوضيح ذلك: أنّ هنا مفهومين:
أحدهما: إبقاء العقد، ونقيضه رفعه، ويعبّر عنه بالفسخ، كما فسّره به بعض اللغويّين.
وثانيهما: الوفاء بالعقد، وهو ترتيب آثار مقتضاه عليه، ونقيضه وهو عدم ترتيب آثار مقتضاه عليه. وصدق الوفاء على ترتيب أثر العقد عليه موقوف على تحقّق المهفوم الأوّل؛ ضرورة أنّ بعد انفساخ العقد، أو إقالته لا يسمّى العمل بمقتضاه وفاءً، وحينئذ، فاذا صدر من أحد المتعاقدين فالشكّ في رفعه للعقد لم يكن دلالة الآية على وجوب الوفاء قاطبةً بعدم تأثير ذلك الشيء في رفعه، ولئن سلّمنا أنّ الوفاء أعمّ من الإمضاء، والعمل بالمقتضي كان مقتضى الآية - حينئذٍ - حرمة الفسخ، ولا ملازمة بينها وبين عدم تأثيره [ و ] عدم ترتيب أثر العقد بعد الفسخ عند الشك في رافعيّته للعقد التي يلزمها عدم تأثير الفسخ لا يستفاد من الآية سواء كان الفسخ حراماً أم لا، واستصحاب بقاء العقد عند الشك في تحقّق الواقع مع كونه مثبتاً؛ إذ ليس من أحكام العقد عند وجوده كون ترتّب الأثر عليه وفاءً يغنينا عنه استصحاب نفس مقتضى العقد.
____________________
(١) المائدة: ١.
وربّما يناقش في دلالة الآية: بأنّ مقتضاها ترتيب آثار مقتضى العقد، إن لزوماً أو جوازاً عليه. وفيه ما مرّت الإشارة اليه من أنّ الجواز، واللزوم من أحكام العقود لامر مقتضياتها.
ومنها: قوله: (الناس مسلّطون على أموالهم)(١) . بناء على أنّ سلطنة الغير على تملّك مال المالك بغير رضاه منافٍ للسلطنة المطلقة، المستفادة من العموم المذكور.
ومنها: قولهعليهالسلام : (لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطيب نفسه)(٢) فإنّه دلّ على أنّ التصرّف في مال الغير - الذي من أفراده بملكه - لا يكون حلالاً إلا بالطيب.
ومنها: قوله: (المؤمنون عند شروطهم)(٣) وقد حكي الاستدلال به عن جماعةٍ منهم المحققّ الأردبيلي(٤) -قدسسره - : و هو مبنيّ على أنّ الشرط مطلق الإلزام و الإلتزام ولو ابتداءاً كما يظهر، وربّما يمنع ذلك، لأنّ المتبادر منه عرفاً خصوص الإلتزام التابع، مؤيّداً بتصريح صاحب القاموس(٥) : بأنّه إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه. ولكن، لا يبعد دعوى العموم [ نظراً ] الى بعض موارد الاستعمال.
ومنها: قوله: (ما الشرط في الحيوان)؟ فأنّ الظاهر، أنّ المراد بالرضا التسليم، وقرّره في بيع الحيوان، مع أنّه يمكن الاستدلال مع الاختصاص بأنّ العقد المشروط فيه شيء اذ الشكّ في لزومه كان شرطه لازماً للعموم المذكور فهو لازم، للإجماع على عدم التفكيك بينهما من طرف العقد، ويتمّ المطلوب في صورة عدم الإشتمال على الشرط بعدم القول بالفصل.
وفيه: مع إمكان دعوى ظهور الفقيه على تقدير تسليم اختصاص الشرط بالواقع
____________________
(١) عوالي اللئالي: ج ١ ص ٢٢٢ ح ٩٩.
(٢) عوالي اللئالي: ج ١ ص ٢٢٢ ح ٩٨.
(٣) عوالي اللئالي: ج ٢ ص ٢٥٧ ح ٧ ووسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الخيار ح ١ و ٢ ج ١٢ ص ٣٥٣ فيه: المسلمون.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان: ج ٨ ص ٣٨٣.
(٥) القاموس المحيط: ج ٢ ص ٣٦٨.
في ضمن عقدٍ في لزوم الوفاء، ما دام العقد باقياً، لأنّ التابع لا يزيد على متبوعه. إنّ الأمر دائر في الشرط المذكور بين أن يكون داخلاً في العموم، وبين أن يكون في المخصّص، وهو الإجماع على عدم لزوم الشرط الواقع في ضمن العقد الجائز.
والظاهر، أنّ شيئاً منهما لا يكون هو المرجع إلاّ أن يقال: إنّ جواز العقد مانع عن لزوم الشرط، والبناء - حينئذٍ - على الرجوع الى العموم عملاً بالمقتضى للشك في المانع.
وفيه أيضاً: منع أنّ المستفاد من عدم لزوم الشرط الابتدائي، والواقع في ضمن العقد الجائز أنّ المقتضي للّزوم هو العقد، لكون الشرط بمنزلة الجزء منه، ثمّ إنّه يرد على التمسّك بالحديث على تقدير عموم الشرط الابتدائي منه، نظير ما ذكرنا في الاستدلال بـ (أوفوا بالعقود) لأنّ العمل على مقتضى الشرط إنّما يعدّ التزاماً ما دام باقياً عرفاً عند العرف، وشرعاً عند الشارع، فالشكّ في ذلك يوجب الشكّ في صدق الإلتزام بالشرط على العمل بمقتضى الشرط، ولا ريب أنّه لا وجه للتمسّك بالكبرى مع الشكّ في ثبوت الصغرى.
الثاني: من وجوه الأصل: الاستصحاب، وهو استصحاب بقاء ما يقتضيه من الملكيّة.
وقد يقال: إنّ الأصل عدم انقطاع علاقة المالك عن العين، إذ الخيار منشأ عدم انقطاع علاقة المالك - كما يظهر من كلامهم - وهذا الأصل حاكم على أصالة بقاء مقتضى العقد، لأنّ الشكّ فيه كان من الشكّ في انقطاع علقة المالك الأصليّ وعدمه.
وأورد عليه: بأنّ المستصحب إن كان هو علاقة الملكية، أو ما يكون من لوازمها فانقطاعها معلوم بواسطة صحّة البيع، إذ لا معنى لها إلاّ لحصول النقل، وإن كان هو السلطنة على إعادة العين - فهي إن كانت - فهي حادثة بعد العقد، ضرورة منافاتها للملكية، مضافاً الى أنّ حكمة الخيار - وهي دفع الضرر - أو الإرفاق المرويّ في جهات الفعل بحسب مصالح البائع أنّما يتحقّق بعد البيع، لأنّ البائع ما لم يخرج
المال من يده لا يكون مورداً للإرفاق عنه.
وإن كان هو الخيار الثابت بالشرع - وهو خيار المجلس - فانقطاعه بالأمرين معلوم، مضافاً إلى أنّه ليس أصلاً كلّيّاً - حينئذٍ - لخروجٍ بالإخبار فيه أصلاً عنه.
الثالث: المعنى اللغوي، فالمعنى إنّ الذي يقتضيه البيع - وهو مبنيّ عليه - هو اللزوم بحيث متى كان بينهما انفكاك فهو لأجل عروض سببٍ خارجيّ عن طبيعة البيع كحدوث حقّ.
وحاصله: أنّ طبيعة البيع ليست كطبيعة بعض العقود الجائزة التي لا تقتضي اللزوم، بل هي مقتضية للجواز، ولا ينفكّ عنها إلاّ المانع الخارجيّ كقصد القربة - مثلاً - بل هي مقتضية للّزوم عرفاً وشرعاً، وانفكاكه عنها لعروض سبب واقع لاقتضاء الطبيعة.
ولكن، لا يخفى أنّ هذا الأصل لا ينفع عند الشكّ في اللزوم من جهة عروض المانع، بمعنى أن يكون هو المرجّح لرفع حكم هذا الشك.
والحاصل: انّ مع تأسيس هذا الأصل لا يقع الشكّ في اللزوم من حيث اقتصار الطبيعة، والشكّ فيه من حيث حدوث مقتضى الجواز المانع عن تأثير الطبيعة لا يندفع به، لأنّ وجود المانع لا ينافي إلاّ فعليّة الاقتضاء.
الرابع: الراجح، فالمعنى أنّ الراجح في البيع بالنظر إلى غلبة لزومه أنّ ما لم يقم دليل على لزومه وجوازه يكون لازماً.
وفيه : - مضافاً الى عدم الدليل المجوز للرجوع إليه - إنّ ذلك ممنوع إن اريد غلبة اللزوم بملاحظة الأفراد، فأنّ لغلبة أفراد البيع ينعقد جائزاً لخيار المجلس، وليس بمفيد في الأفراد المشكوكة إن اريد غلبة الأزمان.
هذا كلّه في الشبهة في اللزوم من حيث الحكم الابتدائي. وأمّا الشبهة فيه من حيث الشبهة في دخول العقد الخارجي في العقد الجائز أو اللازم فالمرجع هو العمومات المذكورة، إن كان البناء على الرجوع الى العموم في الشبهات المصداقية مطلقاً، أو إذا كان المخصوص من قبل المانع بناءً على ما مرّ، من أنّ مقتضى الخيار مانع،
وأنّ اللزوم من مقتضيات طبيعة البيع، وإلاّ فالمرجع هو الاستصحاب، إلاّ أن يكون أصل موضوعيّ حاكم عليه كأصالة عدم قصد القربة عند الشك في أنّ العقد الواقع صدقة أو هبة، بناءً على اتّحاد حقيقتهما، ومنع القصد المذكور عمّا تقتضيه طبيعة العقد من الجواز.
ثمّ إن أصالة مقتضى العقد إنّما تؤثّر في ترتيب آثار نفس المقتضي. وأمّا الأحكام التابعة لعنوان العقد فلا يثبت به، فلو شككنا في أنّ العقد هبة أو بيع لا يحكم بوجوب العوض، بل الأصل براءة ذمة من انتقل إليه المال عن العوض.
هذا كلّه عند الشكّ في العنوان الأوّليّ، ففي المثال المفروض مع القطع في الفساد، يحكم بالضمان إن قلنا أنّه لعموم (على اليد)(١) على وجه، وهو البناء على الرجوع الى العموم في الشبهة الخارجية، وكونها مجانية من قبيل المانع، فتأمّل.
وإن قلنا: إنّه للاقدام على الضمان أو للعموم المذكور، ومنعنا عن الرجوع إليه عند الشكّ لمنع المانعية، أو منع الفرق بين كون المخصّص مانعاً، وبين عدمه فأصالة براءة ذمّة من تلف في يده المال سليمة عن المعارض، مأمونة من حكومة الحاكم، وورود الوارد.
القول في أقسام الخيار - الاول خيار المجلس
وهي كثير:
منها: خيار المجلس، وهو حقيقة خيار الإجتماع؛ إذ هو المناط في البقاء والسقوط، وجوداً وعدماً، فإضافة الى مكان الإجتماع؛ لإختصاص ثبوته بذلك المكان ونحوه.
____________________
(١) عوالي اللئالي: ج ١ ص ٢٢٤ ح ١٠٦.
ويحتمل أن تكون من قبيل إضافة المسبّب إلى السبب تنزيلاً لاسم المكان منزلة ما يقع فيه من الإجتماع، وإختصاص المجلس لغلبة وقوع الإجتماع فيه دون المقام ونحوه.
ويقرب هذا الإحتمال مع مجازيّة الإضافة - بناء عليه - بعينه في نظائره كخيار الغبن والعيب، وتخلّف الشرط، وإن كان بينها وبين الاجتماع فرق من حيث أنّها علل محدثة، وهو علّة مبقية. والأمر سهل.
ولا خلاف في ثبوته في الجملة بين الإمامية، بل اعترف جماعة من العامّة كالشافعيّ(١) وغيره، ودعوى استفاضة النصوص من النبيّ -صلىاللهعليهوآله - والأئمةعليهمالسلام به مستفيضة، فمخالفة من هو شأنه لا يعبأ به، كموافقته على الرواية الحاكية لقول عليعليهالسلام : (إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب)(٢) مؤوّل، وحمله على التقيّة لا وجه له، إذ موجبها حادث في عصر الصادقينعليهماالسلام .
فالظاهر أنّه لا فرق بين أقسام البيع في ذلك، لإطلاق الأخبار المثبتة له. ثمّ إنّه لا إشكال في ثبوته للمالكين إذا كانا هما بل هو المتيقّن من موارد شمول الأخبار.
وأمّا الوكيلان، فظاهر بعض العبائر كعبارة التذكرة(٣) ثبوته لهما مطلقاً، وهو في الوكيلين لإجراء العقد خاصّة مشكل، بل الظاهر عدمه، لأن من الأخبار ما لا يشملها، كقوله: (التاجران إن صدقا بورك لهما)(٤) لعدم صدق التاجر على مثلهما.
وقوله في صحيحة محمد بن مسلم: (البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وصاحب
____________________
(١) الأمّ: ج ٣ ص ٤.
(٢) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الخيار ح ٧ ج ١٢ ص ٣٤٧ فيه وجب وان لم يفترقا.
(٣) تذكرة الفقهاء: كتاب المتاجر في الخيارات ج ١ ص ٥١٨ س ٣٠.
(٤) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب أحكام العقود ح ٢ ج ١٢ ص ٣٨٣ فيه: اذ التاجران.
الحيوان بالخيار ثلاثة أيام)(١) فأنّ الظاهر أنّ قوله: (وصاحب الحيوان) بيان لأحد البيعين اللذين حكم بالخيار والذي يشملهما بإطلاقه متفرّق الى غيرهما، مضافاً الى أنّ الخبرين السابقين بعد القطع باتّحاد المقصود من الأخبار قرينتان على اختصاص الحكم بغيرهما، إلاّ أن يقال: إنّ التعدّي منهما لابدّ منه، لأنّ ظاهرهما خصوص المالكين، ضرورة أنّ الوكيل ليس صاحب للحيوان، ولا يكون البيع له فائدة حتى يكون مباركاً له. وسيأتي أنّ المستقلّين منهما، المعروف بثبوت الخيار لهما.
هذا كلّه مع إمكان أن يقال: إنّ الغرض من الأخبار بيان أنّ من مسقطات هذا الخيار الإفتراق، وهو في الجملة ممّا لا إشكال فيه، ويدلّ عليه كل ما دلّ على ثبوت الخيار، ولا يعتبر فيه كشفه عن رضا المتعاقدين بالعقد فعلاً، وظاهر بعض الأخبار ذلك، ويدفعه إطلاق غيره المؤيّد بالعمل، ولا يعتبر فيه زيادة على مسمّاه، الذي يحصل بأدنى الإنتقال، ولا يعتبر فيه الخطوة ولا أقلّ منها ولا أكثر، والمحكيّ عن الأكثر في تحديد ما يحصل هو به بالخطوة لعلّه محمول على التمثيل، فيما حكي عن بعض من اعتبارها في حصول المسقط لعلّه لا وجه له.
كما أنّه لا وجه أيضاً إشكال بعض في حصوله مع الخطوة أيضاً، لدعوى انصراف الأخبار الى أكثر منها، المؤيّدة لظاهر قولهعليهالسلام : (فمشيت خطى ليجب البيع حين افترقنا)(٢) لإمكان منع الانصراف، وعدم دلالة الرواية بعد جعل زمان الوجوب زمان حصول الإفتراق.ولكنّ الإنصاف، أنّ التبادر لا يخلو عن وجه، فإن ثبت إجماع على كفاية مسمّى الافتراق في مسقط الخيار ولا يبعد، وإلاّ فالمدار على الإفتراق عرفاً، والذي قد يتحقّق بأقلّ من الخطوة كثيراً أو قد لا يتحقّق بالخطوة.
نعم، إن قلنا: إنّ موضوع الخيار هو الإجتماع، وذكر الاقران في غايته لكونه
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الخيار، ح ١ ج ١٢ ص ٣٤٥.
(٢) وسائل الشيعة: ب ٢ من ابواب الخيار ح ٣ ج ١٢ ص ٣٤٨ فيه: ثم رجعت إلى مجلس ليجب.
غايةً، لا لأجل كونه موضوع الحكم ومؤثّراً في رفع الخيار - كما لا يبعد دعوى ظهور الأخبار في ذلك - كان المدار على انتفاء الاجتماع المتحقّق بأوّل ما يتصوّر من الإنتقال، ودعوى التبادر - حينئذٍ - لا وجه له، فالإطلاق محكم. ولكنّ الإشكال في مساعدة الفتوى لهذا الاحتمال.
ثمّ اعلم، أنّ الافتراق حقيقة في المجتمعين في مكانٍ واحدٍ، ولمّا كان المتبايعان أبداً مفترقين كان المراد من افتراقهما زوال الهيئة الاجتماعية الحاصلة عند البيع، وهو كما يحصل بحركة كلّ منهما الى خلاف جانب الآخر، كذلك يحصل بحركة واحدٍ منهما مع سكون الآخر، وحقيقته.
إن قلنا: إنّ دخل السكون في حصوله من قبيل رفع المانع، بمعنى أنّ الحركة مع عدم حركة الآخر الى ذلك الجانب علّة تامّة في حصول الفرقة، حاصلة من أحدهما وهو المتحرك، وإن كان الفعل قائماً بكلّ منهما، وكان نسبة الفاعلية بهذا المعنى الى كلّ منهما صحيحة.
وإن قلنا: إنّ السكون والحركة مجموعهما مؤثّران في حصول الفرقة، كانت حاصلة منهما، كما أنّها - أبداً - قائمة بهما.
وعلى أي تقدير، يكفي في اختياريّته بالنسبة إلى كل قدرته على المنع عن حصول الجهة المنسوبة إليه، فالساكن إذا كان مختاراً في السكون كان قيام الإفتراق به من إختياره، وإن كان المؤثّر في حصوله هو المتحرك.
والحاصل: أنّ نسبة الإفتراق الى شخص قد يكون بملاحظة نفس قيامه به، وقد يكون بملاحظة ذلك مع مدخلية إخباره في ذلك في الجملة بوجه، وعليهما تكون نسبة الإفتراق الى الساكن والمتحرّك على حدّ سواء.
وقد يكون بملاحظة ذلك مع كونه مؤثراً في حصوله، وعليه يمكن منع صحّة النسبة الى الساكن؛ ضرورة أنّ السبب في الحصول هو المتحرك، وهو إنّما كان قادراً على اتّحاد ما يمنع المقتضي الصادر عن المتحرك عن التأثير؛ وهذا القدر لا يكفي في صحّة النسبة بهذا المعنى؛ وحيث كان الإفتراق المسقط للخيار هو بأحد
المعنيين الأو ّ لين؛ لم تكن حركة كلّ منهما الى خلاف جانب الآخر معتبراً في تحقّقه؛ ويدلّ عليه قولهعليهالسلام : (فمشيت خطى ليجب البيع حين افترقنا) حيث نسب الافتراق الى أنفسهما، وجعله مسقطاً مع حصول الحركة منهعليهالسلام خاصّةً، كما هو ظاهر الرواية.
فرع
قال في التذكرة: لو مات أحد المتعاقدين في مجلس العقد احتمل سقوط الخيار، لأنّه يسقط بمفارقة المكان، فبمفارقة الدنيا أولى، وعدمه لإنتفاء مفارقة الأبدان(١) .
وفي التحرير: لو مات أحدهما انتقل الخيار الى ورثته(٢) .
أقول: يمكن أن يقال: مقتضى القاعدة الحكم بعدم الخيار، لا لأنّ الموت من المسقطات، بل لأنّ عدم ثبوته للميّت قطعيّ، ضرورة أنّ الإيجاب يستدعي الموضوع، والأصل عدم ثبوته للوارث، ولا مخصّص له، وإطلاق أخبار ثبوته الى زمان الإفتراق لا يفيد، بعد أن كان موضوعها المتعاقدين.
لا يقال: الافتراق غاية لبقاء أصل الخيار، لا لثبوته للمتبايعين، فقولهعليهالسلام : (البيعان بالخيار ما لم يفترقا) بمنزلة أن يقول: الخيار ثابت للبيعين، وهو باقٍ في صدق عدم افتراقهما. ومقتضاه - حينئذ - بقاؤه بعد الموت لعدم ثبوت الغاية، لأنّا نقول:
ظاهر القضيّة خلاف ذلك، فأنّ ظاهر ذكر الغاية بعد قضية أنّها غاية للقضية بجميع ما اعتبر فيها، مع أنّ قوله: (ما لم يفترقا) - وإن كان سلباً - ظاهر في عدم الإفتراق حال وجود المتبايعين، لا العدم المطلق المجامع لوجودهما وعدمهما.
وهذا لا يصلح إلاّ لتحديد بقاء خيار المتعاقدين، فالمعنى أنّ خيار المتعاقدين مدّة
____________________
(١) تذكرة الفقهاء: البيع، في احكام الخيار ج ١ ص ٥١٧، س ٣٩.
(٢) تحرير الاحكام: البيع، في الخيارات ج ٢ - ١ ص ١٦٦ س ٧.
تركهما الافتراق باق، وبعد حدوثه لا خيار لهما، فلا تعرّض في الخبر لمدّة الخيار من حيث هو، بل لو فرض كون التحديد في الخبر تحديداً لمدّة الخيار - من حيث كان هو - كان مقتضاه القطع بانتفاء الخيار بعد موت المتعاقدين، لأنّ الزمان الذي يترك فيه الافتراق مع قابليّته لوقوع الإفتراق لأجل فقدان من يقوم به الإفتراق. والمفروض أنّ الزمان الذي جعل مدّةً لبقاء الخيار هو الزمان المقيّد بعدم حدوث الافتراق فيه، مع قابليّةٍ لوقوعه فيه.
ونحن إنّما لم نحكم بذلك لأجل أنّ الزمان بهذه الخصوصيّة لا يصلح لجعله مدّةً لبقاء الخيار من حيث هو، وهذا مع قطع النظر عمّا ذكرنا أوّلاً من أنّ الظاهر من القضيّة كون التحديد تحديداً لثبوت الخيار للمتبايعين قرينة بنفسه، على أنّ التحديد لبقاء الخيار للمتعاقدين، لا لبقائه في نفسه.
فتلخّص من جميع ما ذكرنا، أنّ الأخبار لا دلالة فيها على بقاء الخيار بعد الموت، ومعه لا مقتضى للعدول عن أصالة عدم ثبوت الخيار للوارث، إلاّ أن يقال: استصحاب بقاء الخيار بعد الموت حاكم على أصالة عدم ثبوت للوارث.
فان قلت: إنّ الثابت قبل الموت مقطوع الارتفاع، لانتفاء موضوعه.
قلنا: لمّا علم من الخارج أنّ الخيار من الحقوق الماليّة التى اعتبر لها الحدوث والبقاء في نفسه - مع قطع النظر عن ثبوته لمالكٍ - صحّ استصحابه، ولمّا كان من آثار وجوده بعد الموت إنتقاله الى الورثة - لأنّ ما تركه الميّت يكون لوارثه - كان معنى استصحابه بعد الموت انتقاله الى الورثة.
وأمّا الأولويّة المتمسّك بها لسقوط الخيار بالموت فثبوتها موقوف على العلم بمناط كون الافتراق بالأبدان مسقطاً، وكونه في الافتراق بالموت ثابتاً، أشدّ من غيره. وتطرّق المنع الى كلتا المقدّمتين واضح.
مسألة: لو أكرها على التفرّق: فإن منعا من التخاير فالمعروف عدم سقوط الخيار. وحكي عن الأردبيلي -رحمهالله - سقوطه مطلقاً(١) وقيل بعدمه مطلقاً، ولو لم
____________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ج ٨ ص ٣٨٨.
يمنعا من التخاير.
واستدلّ الأوّل: بأنّ المتبادر من الافتراق هو ما كان عن رضاً بالعقد.
وبقولهعليهالسلام في صحيحة فضيل: (فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا)(١) دلّ على إناطة السقوط بالافتراق والرضا، وليس المراد منه ما وقع عند الافتراق للإجماع على عدم العبرة لغيره، ومع المنع من التخاير لا يكون الإفتراق عن رضا بالعقد.
ويرد على الأوّل: منع التبادر، وأنّ ترك التخاير إختياراً مع الإكراه على الافتراق لا دلالة فيه على الرضا، ولا يسقطه أيضاً.
اللّهمّ إلاّ أن يقال: لمّا كان الافتراق عرفاً محقّقاً لكمال البيع، وقاطعاً لسلطنة المتعاقدين على ردّ ما نقل اليهما كان الإخبار في ترك التخاير دليلاً على الإلزام، فإنّه لو لم يكن الرضا محقّقاً - حينئذٍ - لظهر منهما ما يدلّ على عدم تحقّقه.
لا يقال ذلك، إنّما يؤثّر اذا لم يعلما أنّ لهما السلطنة على الردّ ما لم يتحقّق الافتراق والرضا. وأمّا مع العلم بذلك فلعلّ ترك التخاير لأجل علمهم بأنّ هذا الافتراق لا يؤثّر في السقوط، وعلمهم ببقاء تمكنهم من الردّ.
لأنّا نقول: إنّما نعني من الافتراق عن رضا هو ما كان عند العرف التزاماً بالعقد، ومحكوماً بأنّه عن رضا بالعقد، مع قطع النظر عن جعل الشارع سلطنة الردّ ما لم يحصل الأمران.
ويرد عليه أيضاً: أنّ مقتضى حديث الرفع بعد عمومه لرفع جميع الآثار، ولكلّ شيء حتى جزء السبب أن يكون الافتراق الواقع عن إكراه، أو اضطرار غير مؤثّرٍ في السقوط، وأن يكون وجوده كعدمه، إلاّ أن نمنع شموله لجزء المقتضي.
أو يقال: إنّ المعلوم من تتبّع الموارد أنّ الامور التي انيط تأثيرها بالرضا لا يؤثّر
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب ١ من ابواب الخيار ح ٣ ج ١٢ ص ٣٤٦.
الإكراه فيها إذا كان الرضا متحقّقا. ألا ترى أنّ البيع عن إكراهٍ لو ألحقه الرضا يؤثّر أثره، ولا يحكم بأنّه خرج عن قابليّة التأثير.
ويرد على الثاني: أنّ ظاهر الخبر لا يعمل به، للإجماع على أنّه لا يعتبر في سقوط الخيار حصول الرضا فعلاً.
ودعوى أنّ قولهعليهالسلام : (بعد الرضا) قرينة على أنّ المراد من الافتراق هو الكاشف عن الرضا نوعاً، وما وقع عن إكراه إذا كان مع المنع من التخاير لا يكشف عنه نوعاً، ومع عدم المنع كاشف عنه، ويلحق به الخارج عن الاختيار مع القدرة على التخاير، لعدم القول بالفصل مدفوعة بأنّه: كما يمكن ان يكون قولهعليهالسلام : (بعد الرضا) كناية عن الافتراق الخاص، وهو الكاشف نوعاً عن الرضا، ويكون تكراره إشارةً الى علّة الحكم لسقوط الخيار بالافتراق، فيعتبر قرينة على أنّ المراد من الافتراق - حيث أطلق - هو خصوص ما كان عن رضاً بالعقد.
كذلك يمكن أن يكون المراد عدم الفسخ، وبقاء الرضا الحاصل عند العقد. ومع ذلك لا يصلح لتقييد المطلقات، خصوصاً مع كثرتها وخلوّها عمّا يشير الى ذلك، وخصوصاً مع كونها في مقام إعطاء الضابط للخيار بقاءً وارتفاعاً.
مع أنّ الظاهر من الصحيحة بعد التأمّل أنّ المقصود به بيان الحكم من حيث الثبوت والارتفاع. هو قولهعليهالسلام : (البيعان بالخيار ما لم يفترقا) وأنّ قولهعليهالسلام : (فاذا افترقا) ليس المقصود منه إلاّ بيان مفهوم قوله: (ما لم يفترقا).
وهذا يشهد بأنّ قوله: (بعد الرضا) المراد منه ما ينافي مفهوم الأوّل حتى يصير قرينةً على عدم إرادة الإطلاق من الغاية، مع أنّا لو بنينا على أنّ المسقط هو الافتراق الكاشف عن الرضا لزم منّا أن نقول بأنّ الافتراق الإختياري، وغير إكراه إذا كان في حال الغفلة عن وقوع العقد لا يكون مسقطاً.
والظاهر أنّ أحداً من الأصحاب لا يلتزم بذلك، إلاّ أن يقال: إنّ الغفلة لا تكون إلاّ عن الإعراض عن حال المعاملة، والاشتغال بغيرها، وهو غالباً لا يكون
بعد الرضا بالعقد، واطمئنان الخاطر في مطابقة المنقول الى كلّ منها لغرضه، واشتماله على ما دعاه الى الإقدام على المعاوضة، فيكون الافتراق في تلك الحالة عن الرضا بالعقد، وكاشفاً عن حصوله نوعاً.
وممّا يمكن أن يقال: هو أنّ عدم الإفتراق المجعول في جملةٍ من الأخبار مبيّناً لمدّة الخيار، كناية عن الاجتماع، وأنّ الافتراق - حيث جعل غايةً - كما في قوله: (حتى يفترقا) اعتبر لأجل كونه في نفسه، وفي حدّ ذاته غايةً لمدّة الخيار، حيث إنّ مدّتها الاجتماع الذي ينتهي عقلاً الى الافتراق، فليس في الافتراق على هذا - من حيث إنّه افتراق - حكم شرعي، وليس المراد منه - ايضاً - خصوص الاختياريّ منه؛ ضرورة أنّه لا تفاوت في الغائيّة العقلية بين أصناف الافتراق وأنواعه.
وملخّص معنى الأخبار على ذلك: كون البيعين بالخيار عند الاجتماع، فاذا ارتفع ذلك بأيّ سبب كان يرتفع الخيار لارتفاع ما يقتضيه، وهو الاجتماع، ولعلّه الى ذلك نظر من جعل الافتراق مطلقاً مسقطاً.
وهذا الكلام، وإن لم يكن بعيداً في نفسه، ويساعده الاستعمالات العرفيه فانه كثيراً ما يعبّرون لعدم أحد الضدّين عن وجود الآخر، ويجعلونه كنايةً عنه. ولكنّه مع عدم شاهد واضح عليه في الأخبار مخالف لفتوى معظم الفقهاء، فالعدول عن ظاهر الأخبار - الّذي هو إناطة سقوط الخيار بالافتراق الاختياري، أعني ما يقابل الاضطرار الى ذلك - في غاية الإشكال.
كما أنّ المعدول عنه الى ما يطابق فتوى المشهور - وهو إناطة السقوط بالافتراق بأيّ وجهٍ اتفق - إذا كان كاشفاً عن الرضا بالعقد، ولو كان عن إكراهٍ أو اضطرار - ايضاً - مشكل؛ لماعرفت من عدم وجود ما يصلح الإتكال اليه في إرادة خلاف هذا الظاهر في المقام.
فما ذهب اليه بعض من قارب عصرنا، بأنّ الافتراق الاختياري مسقط الاّ ما وقع عن إكراه، ولو مع عدم المنع من التخاير، لاقتضاء حديث الرفع خروجه عن
الإطلاقات ورفع حكمه - الّذي هو إسقاط الخيار - بناءً على عمومه لرفع الآثار الوضعية، لا يخلو عن قوةٍ إن لم يكن إجماع على خلافه.
ولكنّ المصير اليه - بعد فتوى المشهور بالسقوط - بالافتراق مطلقاً ما لم يمنع عن التخاير، والاجماع المحكي عن السيّد عميد الدين(١) - كما ستأتي الإشارة في المسألة الآتية - أيضاً في غاية الإشكال.
وممّا ذكرنا، عرفت أنّ مقتضى تبادر الاختيار من الفعل المسند الى الفاعل المختار، وحديث (رفع ما استكرهوا عليه)(٢) هو القول بسقوط الافتراق عن إكراهٍ عن الاعتبار مطلقاً، وربّما يجعل الأمران دليلاً لفتوى المشهور.
ولعلّ المراد من تبادر الاختيار هو ما يقابل الإكراه، دون ما يقابل الاضطرار، وهو بهذا المعنى ممنوع.
بل يمكن أن يقال: إنّه بعد شمول الأخبار، الافتراق عن إكراه دخل الاضطراري - أيضاً - بضميمة عدم القول بالفصل بينهما، ومقتضاه القول: بأن الافتراق مطلقاً مسقط للخيار، كما مرّ حكايته عن بعض.
والتمسك بحديث الرفع - أيضاً - أن يقال: إنّ الاخذ بمفهوم الغاية في الاضطراري بضميمة عدم القول بالفصل ليس بأولى من الأخذ بالمنطوق في الإكراه بضميمة عدم الفصل فتأمّل. لا ينفع للمشهور بعد إلتزامهم بأنّ الافتراق عن إكراه أو اضطرار مسقط في الجملة في الحكم، بأنّ المقرون بالمنع من التخاير لا يكون مسقطاً للخيار.
والإنصاف، أنّ المسألة من المشكلات، وليس غير التوقف عنها والاحتياط طريقاً للنجاة.
____________________
(١) المكاسب (للأنصاري): ص ٢٢٣، خيار المجلس س ٣١.
(٢) وسائل الشيعة: ب ٣ من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢ ج ٥ ص ٣٤٥.
مسألة: لو أكره أحد المتعاقدين على الافتراق، وترك التخاير، وبقي الآخر في مجلس العقد مختاراً ففي سقوط خيارهما، أو المختار خاصةً، أو عدم السقوط مطلقاً، أقوال(١) .
واعلم، أنّ الاختلاف في هذه المسألة مبنيّ على القول: بأنّ الافتراق عن إكراههما لا يكون مسقطاً: إمّا مطلقاً، كما هو خيرة بعض من قارب عصرنا، أو مع منعهما عن التخاير كما هو المحكي عن المشهور(٢) .
وأمّا بناء على القول: بأنّه مسقط مع إكراههما بالسقوط، مع بقاء اختيار أحدهما أولى.
واعلم أيضاً: أنّ اعتبار المنع من التخاير في عنوان المسألة مبنيّ على مذهب المشهور، من اعتباره في سقوطه عن الاعتبار بالاكراه.
وأمّا على قول البعض، من كون الإكراه مطلقاً مانعاً عن التأثير في السقوط فلا فرق - حينئذٍ - بين اقتران الإكراه على التفرق بالمنع عن التخاير، وبين عدمه.
والظاهر أنّ مبنى الخلاف هو أن افتراقهما المجعول غاية للخيار المفيد بكونه عن الاختيار - بناءً على خيرة البعض - والمطلق الشامل لقسمي الاختياري والاضطراري، المفيد لعدم المنع والتخاير يتوقف تأثيره مطلقاً، أي في سقوط خيار كلّ على حصوله مع الشرط من كلّ منهما، فمع عدمه معه منهما، ولو حصل من أحدهما معه يبقى الخياران، كما هو المحكيّ عن ظاهر المبسوط(٣) ، والمحقّق(٤) والشهيدين الثانيين(٥) – قدس سرهم ا - ومحتمل الإرشاد(٦) ، أو يكفي فيه مطلق حصوله مع الشرط
____________________
(١) المكاسب: الخيارات ص ٢٢٣.
(٢) المكاسب: الخيارات ص ٢٢٢.
(٣) المبسوط: ج ٢ ص ٨٤.
(٤) جامع المقاصد: ج ٤، ص ٢٨٣.
(٥) مسالك الافهام: في الخيار ج ١ ص ١٧٨ س ٩.
(٦) ارشاد الاذهان: ج ١ ص ٣٧٤.
من أحدهما، فيسقط الخياران، كما هو المحكيّ عن ظاهر المحقق(١) والعلاّمة(٢) وفخر الإسلام(٣) والسيّد عميد الدين(٤) ، أو يتوقّف تأثيره بسقوط خيار كلّ على حصوله منه مع الشرط، فيسقط خيار المختار خاصّةً، كما هو المحكيّ عن الخلاف(٥) ، وجواهر القاضي(٦) .
واعلم؛ أنّ مقتضى ما ذكرنا عدم الفرق بين هذه المسألة وعكسها، وهو كون الباقي في المجلس مكرهاً، ومفارق المجلس مختاراً.
وحكي عن العلاّمة في التحرير(٧) : التفصيل بين المسألتين، فحكم في محلّ البحث ببقاء الخيارين، وفي عكسها بسقوطهما.
ولعلّه مبنيّ على أنّ الافتراق الذي جعل غايةً للخيار هو الذي يكون فعلاً لمن قام به، بمعنى كونه كون سببه الذي هو الحركة الى خلاف جانب صاحبه قائماً به، ولو كان قيامه به عن كره، أو اضطرار - مع حصول الشرط الذي هو القدرة على التخاير؛ ضرورة أنّه على ذلك - لم يحصّل الغاية، وهو الافتراق بهذا المعنى خاصّاً للشرط الذي هو القدرة على التخاير في هذه المسألة، لأنّ المختار في ترك التخاير لم يقسم به حركة يؤثر في الافتراق، وهو في العكس حاصل.
وأقول: الظاهر أنّه لا وجه لهذه الدعوى، بعد البناء على أنّ الافتراق بأيّ وجهٍ اتّفق، حتى الاضطرار إذا كان مع القدرة على التخاير مسقطاً للخيار؛ فأنّ من ادّعى لا محيص له من القول بأنّ المراد من قوله:(حتى يفترقا) حتى يقوم الافتراق
____________________
(١) شرايع الاسلام: ج ٢ ص ٢١.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥١٨.
(٣) المكاسب: الخيارات ص ٢٢٣.
(٤) المكاسب: الخيارات ص ٢٢٣.
(٥) الخلاف: ج ٣ ص ٢٦ مسألة ٣٥.
(٦) جواهر الفقه: ص ٥٥.
(٧) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٦٦ س ٣.
بهما. ولا ريب أن قيامه بهما لا يتوقّف على صدور الحركة منهما، بل يتوقّف على أحد أسبابه الذي منها ذلك، ومنها حركة أحدهما، وبقاء الآخر في المجلس، وحينئذ، فاذا بنينا على أنّ القيام بأحدهما - ولو اضطراراً - اذا كان مع القدرة على التخاير مسقط للخيارين بحسب القول بالسقوط في فرض المسألة.
نعم، من بنى أنّ الاختياري خاصّة مسقط، له أن يقول: إنّ معنى قوله: (حتى يفترقا) حتى يصدر الافتراق منهما، لا حتى يقوم بهما اختياراً، فله في فرض المسألة أن يقول: إنّ الغاية - وهو صدور الافتراق من أحدهما - لم يحصل خاصّاً للشرط، وهو عدم كونه مكرهاً عليه.
واعلم - أيضاً - أنّ ظاهر التذكرة(١) ، أنّ الخيار في مفروض المسألة، فيسقط ممّن حصل منه الافتراق، الجامع للشرط، وخيار الآخر يسقط بالتبع. وعبارته المحكيّة عن القواعد(٢) - أيضاً - ظاهرها ذلك، وهو المفهوم من المحكيّ عن الفخر في شرح عبارة القواعد(٣) ، بل ربّما يستظهر منهما أنّ لا خلاف في عدم انفكاك الخيارين في السقوط، وعليه: فالتفصيل بين المختار وغيره لا وجه له، خصوصاً مع حكاية الاجماع عن السيّد عميد الدين، على أنّ الخيارين يسقطان مع افتراق أحدهما.
وكيف كان، فالذي يظهر من الأدلّة - مع قطع النظر عن الإجماع المحكيّ - هو القول ببقاء الخيارين، وذلك: إمّا بناءً على مذهب المشهور في أن المسقط للخيار أعمّ من الاختياري، فلأنّ ما دلّ على تقييد الافتراق بكونه عن رضاً بالعقد يقتضي اعتبار رضاهما في ذلك. وأما بناءً على تبادر خصوص الافتراق عن رضاً من قوله : (حتى يفترقا) فظاهر.
وكذلك الأمر، إن كان التقييد بالرضا لقولهعليهالسلام في صحيحة فضيل
____________________
(١) تذكرة الفقهاء : ج ١ ص ٥١٨.
(٢) المكاسب: الخيارات ص ٢٢٣ س ٣٢.
(٣) قواعد الاحكام: جزء ١ ص ١٤٢.
(بعد الرضا منهما) وحمله على حصول الرضا من المجموع المتحقّق برضا واحدٍ منهما خلاف الظاهر لا موجب له، عدا إجماع السيد عميد الدين الذي قد عرفت سبقه بالخلاف، ولحوقه به.
وقولهعليهالسلام في حكاية شرائه الأرض: (فلمّا استوجبتها قمت، فمشيت خطوةً ليجب البيع حين افترقنا) بعد تأييده بفتوى الجماعة بسقوط الخيار إذا مات أحدهما، أو نام، أو غفل وفارق الآخر إختياراً، بناء على ظهوره في حصول الافتراق منهعليهالسلام في حال غفلة البائع، وظهوره في ذلك ممنوع، بل الذي يظهر هو أنّ التعجيل في المفارقه لأجل أن يسقط الخيار قبل أن يلتفت البائع الى ما لعلّه يوجب تردّده في البيع فيفسخ، وليس فيه ما يدلّ على غفلته عن أصل الافتراق، بل التأمّل الصادق ربّما يوجب الحكم بأنّه كان الافتراق في حال شعوره بحصوله.
ودعوى أن جعلهعليهالسلام مجرّد مشيه سبباً لصدق الافتراق المجعول غاية للخيار، وجعل وجوب البيع علّةً غائيّةً له، من دون اعتبار رضا الآخر، أو شعوره بمشي الإمامعليهالسلام يقتضي عدم اعتبار رضا الآخر في حصول غاية بخيار مندفعة بأنّه: إن أراد أنّ جعل السبب لحصول الافتراق المسقط هو المشيء مجرّداً عن قيد يقتضي أن يكون المسقط أمراً يترتب على المشي، وهو ليس إلاّ الافتراق، لأنّه لا دخل للمشي في حصول رضا الآخر، فلو كان معتبراً لم يكن المشي سبباً لحصول الغاية، وكان هو بضميمة أمرٍ آخر سبباً.
ففيه: أنّه ليس ظاهر الخبر كون المشي سبباً تامّاً في حصول المسقط، إذ ليس فيه إلاّ أنّ الغرض حصول المسقط، ويكفي في كونه غرضاً ولو كان أمراً لا يترتّب على مجرد المشي حصول سائر ما يتوقف عليه وجود المسقط.
نعم، لو فرض أنّ رضا الآخر منتفٍ كان دخله في حصول الغاية منافياً لكون غرض الإمامعليهالسلام من المشي المجرد حصول المسقط؛ للعلم بأنّه لا يترتب ذلك على المشي - حينئذٍ - ولكنّ صدق هذا الفرض ممنوع، ودعوى ظهور الخبر فيه قد عرفت منعها.
وإن أراد أنّ جعل سقوط الخيار غاية للافتراق المجعول غاية للمشي من غير اعتبار رضا الآخر، حتى في ترتّب السقوط، يقتضي عدم اعتبار أمرٍ آخر غير الافتراق.
ففيه: إنّ إطلاقه على ذلك يقتضي عدم اعتبار الرضا مطلقاً، ومجرد حصول الرضا في الجملة، في مورد الرواية لا يقتضي تقييد إطلاقه بعد عدم قيام ما يدلّ أنّ قيود المورد معتبر في الحكم. وحينئذٍ: فإمّا أن يعمل بالخبر فيجب الحكم بعدم اعتبار الرضا مطلقاً، أو بالصحيحة، فيجب الحكم بكون الرضا منهما معتبراً، والتبعيض في الرضا طرح لظاهر الخبرين.
هذا كلّه، مع أنّ إطلاق الخبر لا حجّة فيه، فأنّ الكلام ليس مسوقاً لبيان الحكم، وإنّما الغرض منه بيان علّة التعجيل، الذي لم يكن في نظر السائل، من دون حدوث غرض يختصّ به ممدوحاً.
هذا كله على مذهب المشهور. وأمّا على ما اختاره البعض - وقويناه في الجملة - فيمكن أن يقال: إنّ المتيقّن خروجه عن إطلاق الافتراق الاختياري هو ما وقع من كلّ منهما عن إكراه ولا دليل على خروج ما وقع من أحدهما عن إكراه، فيسقط به الخياران.
ويدفعه، أنّ ما وقع من أحدهما عن إكراهٍ بمنزلة العدم - بناءً على شمول الحديث لجزء السبب فلا يكون افتراقهما حاصلاً.
وينفي الكلام - حينئذٍ - في أنّ غاية خيار كلّ منهما افتراق كليهما، أو يكفي في سقوطه من أحدهما افتراقه.
والظاهر من الأخبار، امتداد الخيارين إلى زمان حصول الافتراق منهما، واحتمال التوزيع خلاف الظاهر، خصوصاً في مثل المقام الذي تكون الغاية فيه فعلاً واحداً، وتعدّد النسبة فيه ناشئاً من تعدّد الجهة.
وأضعف من هذا الاحتمال، احتمال كون مسمّى الافتراق المتحقّق بحصوله
من أحدهما غاية للخيارين، وإرادة الاستغراق الإفرادي من قوله: (حتى يفترقا) لا يقتضي ذلك، بل مقتضاه كون الاستغراق غايةً، كما يظهر بأدنى تأمّل.
هذا غاية ما يسع لنا من الكلام في هذه المسألة، وهي كسابقتها في غاية الإشكال، والاحتياط حسن على كلّ حال.
وعلى اللّه الإتّكال، وخير ختام. تمّ على يد أقلّ السادات، السيّد محسن الخوانساريّ.
الثاني - خيار الحيوان
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
الحمد للّه ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيّبين الطاهرين، ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين الى يوم الدين.
وهو في الجملة ممّا لا إشكال في ثبوته عندنا، والكلام فيه يقع في مسائل:
الاولى: الظاهر أنّ هذا الخيار ثابت في كلّ حيوان، حتى مثل دود القز، والجراد، لعموم قولهعليهالسلام : (في الحيوان كلّه شرطه ثلاثة)(١) المؤيّد بإطلاق غيره من الأخبار، وبكثرة النصوص(٢) الدالّة على ثبوته في بعض ما يتوهّم انصراف الأخبار الى غيره كالإماء، وباطلاق فتاوى الأصحاب.
فدعوى انصراف الأخبار الى بعض أنواع الحيوانات في غاية الضعف.
نعم، يمكن دعوى خروج ما لا يقصد من بيعه، حياته كالسمك المخرج من الماء، والجراد المجتمع في الإناء، لأنّ الظاهر، أنّ الخيار من أحكام عنوان بيع
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب ٣ من ابواب الخيار ح ١ ج ١٢ ص ٣٤٩ فيه: شرط ثلاثة ايام.
(٢) وسائل الشيعة: ب ٣ من ابواب الخيار ص ٣٥٠ - ٣٤٩.
الحيوان، وهو لا يصدق على البيع عليها عرفاً. لأنّه وقع عليها من حيث كونها لحماً، وإن صدق عليه أنّه بيع الحيوان لغةً. وهذا فيما تعارف وقوعه كالمثالين ظاهر.
وأمّا في ما يقع اتفاقاً، مثل بيع الصيد المشرف على الهلاك، لجرح االكلب المعلم، أو لإصابة السهم، ففي ثبوت الخيار وعدمه إشكال، من حيث أنّ ذلك حيوان حقيقةً، وكونه بسبب عروض الحادثة خارجاً عن عنوان الحيوان عرفاً محلّ إشكال.
والحاصل: إنّ مثل السمك، والجراد خارجان عرفاً عن عنوان الحيوان، وملاك خروجهما هنا موجود، وهو الاشراف على الهلاك، فيجب الحكم بعدم الخيار، وإنّ كون ذلك منزّلاً منزلة اللّحم - لندرة وقوعه - غير معلوم.
وكيف كان، فلا ريب في أنّ موتها قبل القبض، أو في زمن الخيار لا يحكم عليه بأنّه تلف عن البائع، فالحكم بخروجه عن الاطلاق لا دليل عليه. فتأمّل. لأنّه لا يصدق عليه تلف المبيع، لأنّ المراد منه تلف ما قصد مقابلته بالثمن، وهو هنا ليس إلاّ اللّحم، وكونه حيواناً لم يكن مقصوداً للمتعاقدين في المبادلة، فالمقابل للثمن لم يقع عليه التلف، ولم يكن الموت إلاّ سبباً لفوات وصفٍ غير مقصودٍ لهما حين البيع، فافهم.
وفي دخول هذا الخيار في بيع الكلّي وجهان:
من أنّه يصدق عليه بيع الحيوان.
ومن أنّ الأخبار منصرفة الى بيع الأعيان الخارجية، مع أن حكم الخيار - وهو المروي للاطلاع على ما لا يعلم إلاّ معه - مفقودة هنا - والأقرب العدم.
ويحتمل الخيار فيما أقبضه البائع أداءاً، بمعنى سلطنة المشتري على ردّه، وطلبه تعيين الكلّيّ في غيره قبل الثلاثة، ولكنّه ضعيف، لأنّه لا يكون تعيين الكلي في بعض أفراده بيعاً لذلك الفرد.
وأمّا السلطنة على فسخ البيع بعد القبض والتعيين فلا ينبغي إشكال في عدمها.
الثانية: المشهور أنّ اختصاص هذا الخيار بالمشتري. وحكي عن الغنية(١) وظاهر الدروس(٢) الإجماع عليه، لعموم قولهصلىاللهعليهوآله : « اذا افترقا وجب البيع »(٣) - حينئذٍ - المشترى خاصّة في بيع الحيوان بالإجماع، وعموم قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) بالنسبة الى ما لا يدخل فيه خيار المجلس بالأصل كبيع الوكيلين في العقد، مع عدم كون الأصليّين في مجلس العقد، أو بالعارض كالمشترط فيه عدم الخيار لما اذا كان الطرفان، أو أحدهما حيواناً. ويتمّ في غيره ممّا يدخل فيه خيار المجلس، لعدم القول بالفصل، ولظاهر غير واحدٍ من الأخبار، وصريح بعضٍ آخر.
فمن الأوّل صحيحة فضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّهعليهالسلام قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قالعليهالسلام : ثلاثة أيامٍ للمشتري: قلت: وما الشرط في غير الحيوان؟ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما(٤) .
وظهور الفقرة الاولى في اختصاص الخيار بالمشتري، وإطلاق نفي الخيار لهما في بيع غير الحيوان يشمل ما اذا كان الثمن حيواناً، إلاّ أن يقال: إنّ اختصاص الخيار بالمشتري، من حيث كون المبيع حيواناً، وعدمه، لهما في بيع غير الحيوان من حيث كون المبيع غير حيوان، لا ينافي ثبوت الخيار لهما، أو لأحدهما من جهة اخرى، مثل كون الثمن حيواناً. والظاهر أنّ السؤال عن الشرط في البيع من حيث كون المبيع حيواناً، أو غير حيوان.
وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّهعليهالسلام قال: في الحيوان كلّه شرطه ثلاثة أيام للمشتري(٥) . ودلالته على الاختصاص بالمشتري، إن جعلنا قوله عليه
____________________
(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب البيع ص ٥٢٥ س ٢٢.
(٢) الدروس الشرعيّة: ص ٣٦١. وراجع جواهر الكلام: ج ٢٣ ص ٢٤.
(٣) وسائل الشيعة: ب ١ من ابواب الخيار ح ٤ ج ١٢ ص ٣٤٦.
(٤) وسائل الشيعة: ب ١ من ابواب الخيار ح ٣ ج ١٢ ص ٣٤٦.
(٥) وسائل الشيعة: ب ٣ من ابواب الخيار ح ١ ج ١٢ ص ٣٤٩.
السلام: (للمشتري) خبراً بعد خبرٍ واضحة؛ فأنّ جنس الخيار من جهة كون المبيع حيواناً، إنّما يختصّ به إذا لم يكن لغيره، وإن جعلناه قيداً للخبر - أعني ثلاثة أيام - فظهورها في الاختصاص لأجل عدم ظهور نكتةٍ رافعةٍ لقبح التقييد على تقدير إطلاق الحكم.
وصحيحة ابن رئاب عن أبي عبد اللّهعليهالسلام قال: الشروط في الحيوانات ثلاثة أيام للمشتري(١) .
وخبر ابن سنان عن أبي الحسن الرضاعليهالسلام قال: الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري(٢) .
ومن الثاني صحيحة ابن رئاب المحكيّة عن قرب الإسناد، قال: سألت أبا عبد اللّهعليهالسلام عن رجل اشترى جارية، لمن الخيار، للمشتري، أو البائع، أو لهما كليهما؟ قال: الخيار لمن اشترى، نظرة ثلاثة أيام، فاذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء(٣) .
وعن سيدنا المرتضى(٤) وابن طاووس(٥) : أنّ الخيار لهما لقولهعليهالسلام في صحيحة محمد بن مسلم: المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا(٦) . وهذا لكونه خاصّاً، وصريحاً في ثبوته لهما، يخصّص العمومات، ويقدّم على ما ظاهره الاختصاص وحجّيّته، لأنّه مسنداً من الصحيحة المحكيّة في قرب الإسناد، لورودها في الكتب الأربعة، التي تقدّم على مثل قرب الإسناد، التي قيل: إنّه من الكتب التي لم يلتفت إليها أكثر الأصحاب، لغفلتهم
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب ٤ من ابواب الخيار ح ١ ج ١٢ ص ٣٥٠.
(٢) وسائل الشيعة: ب ١ من ابواب الخيار ح ٥ ج ١٢ ص ٣٤٦ فيه: علي بن اسباط. (٣) وسائل الشيعة: ب ٣ من ابواب الخيار ح ٩ ج ١٢ ص ٣٥٠.
(٤) الانتصار: في البيع ص ٢٠٧.
(٥) راجع مفتاح الكرامة: ج ٤ ص ٥٥٥ س ٢٧ وجواهر الكلام: ج ٢٣ ص ٢٤.
(٦) وسائل الشيعة: ب ٣ من ابواب الخيار ح ٣ ج ١٢ ص ٣٤٩.
عنها أو عن مراجعتها. ولكون الراوي لها محمد بن مسلم، الذي يقدم هو وأضرابه - مثل زرارة - على غيرهم من الثقاة تقدّم عليها أيضاً، وحيث أنّ الترجيح من حيث الدلالة والسند معها ثبوت الترجيح لما يعارضها بالمرجّحات الخارجية من موافقة المشهور، وأكثرية الرواية، خصوصاً بعد ظهور بدرك الشهرة.
وأمّا الإجماع المحكيّ عن الغنية(١) فمعارض بإجماع السيّد في الانتصار(٢) .
هذا غاية ما يقال في ترجيح هذا القول، ويمكن أن يمنع ترجيح هذه الصحيحة دلالة على غيرها، بعد تأيّدها بعضها ببعض.
بل يمكن دعوى مقاومة صحيحة الفضيل لها بنفسها.
ولا ريب أنّ الترجيح بحسب السند لها لكثرتها، واشتهارها عند الرواة، حتى عند محمد بن مسلم الراوي لهذه الصحيحة، مع تأيّدها بإجماعي الغنية وظاهر الدروس، لتقدّمها على إجماع الانتصار لتأيّدهما بالشهرة، ووهنه بندور القائل به. ولو فرض التكافؤ فالمرجع العمومات، إلاّ أنّ المنع دلالة (أوفوا بالعقود) على أصالة اللزوم - بناءً على ما مرّ - من الإشكال. ويدعى اختصاص حديث الافتراق بغير بيع الحيوان لا تحاد سياقه مع هذه الأخبار، فتأمّل.
و اعلم ، أنّ في المسألة قولاً(٣) ثالثاً حكي نسبةً الى جماعةٍ من المتأخّرين ، منهم الشهيد الثاني في المسالك(٤) ، وهو أنّ الخيار لمن انتقل اليه الحيوان، بائعاً كان أو مشترياً، لعموم صحيحة محمد بن مسلم (المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام). ولا ينافيه قولهعليهالسلام في خبر فضيل: (وصاحب الحيوان المشتري) كغيره من الأخبار السابقة؛ لإمكان أن يقال: التقييد بالمشتري
____________________
(١) تقدم ص ٤٧١ رقم (١)
(٢) تقدم ص ٤٧٢ رقم (٤)
(٣) المكاسب: الخيارات ص ٢٢٥.
(٤) مسالك الأفهام: في الخيارات ج ١ ص ١٧٨ س ٤٠.
فيه، والحكم بالاختصاص به فيها مبنيّ على الغالب من كون الحيوان مثمناً، وكون ثمنه من غير جنسه، مع إمكان منع منافاة تلك الأخبار الصحيحة - بناءً على ما مرّت الإشارة إليه - من أنّ الاختصاص من حيث كون المبيع حيواناً، فلا ينافيه ثبوت الخيار للبائع من حيث كون الثمن حيواناً.
لا يقال: تنزيل التقييد في خبر فضيل على الغالب ليس بأولى من تنزيل إطلاق الصحيحة على الغالب.
لأنّا نقول: لا نسلّم أنّ الغلبة بلغت درجة تصرّف الاطلاق. ولا يوجب ذلك عدم صلاحيتها لتنزيل التقييد عليها، إذ من أفراد الغلبة ما لا يصلح الإتكال عليه في إرادة المقيّد من الاطلاق، ويصلح نكتة لذكر القيد.
بل أقول: حيث أنّ دلالة الخبر وغيرها ممّا دلّ على الاختصاص مبنيّة على عدم نكتة للتقييد، كان احتمال كون الغلبة نكتةً مسقطاً للاستدلال. وأمّا الاطلاق فيجب الأخذ به ما لم يثبت قرينة على التقييد هذا.
ويمكن حمل التقييد في قولهعليهالسلام : (وصاحب الحيوان المشتري) على إرادة رفع إرادة البائع من صاحب الحيوان، حتى كون المبيع حيواناً كما هو الغالب، لأنّه يصحّ إطلاق صاحب الحيوان عليه هذا.
ولكنّ الانصاف، أنّه كسابقه، لا يمكن المصير إليه، لأنّ مثل هذا الاطلاق الموهون يشبه الانصراف الذي ليس دعواه من التقييد ، وبالإجماع المحكيّ عن الغنية وظاهر الدروس ، المؤيّد بالشهرة لا يصلح لتقييد إطلاق قوله : (فاذا افترقا وجب البيع)، المؤيّد ببعض ما مرّ من موهنات معارضة كالإجماع والشهرة.
هذا، مع إمكان منع حجّيّة مثل هذا الاطلاق المقرون بالغلبة - مع قطع النظر عن الموهنات المذكورة - بناءً على أنّه يكون الاطلاق المقرون بالغلبة التي لا يعلم كونها قرينة على عدم الاطلاق، من قبيل اللفظ المقرون بما يصلح أن يكون قرينة المجاز في عدم انعقاد الظهور في المعنى الحقيقي.
المسألة الثالثة:
الظاهر أنّ مبدأ هذا الخيار من حين العقد، لظهور جميع الأخبار في ذلك، حيث أنّها ظاهرة في أنّ القصد بيان امتداد الخيار بعد الفراغ من كون المبدأ من حين العقد، فلو انقضت الثلاثة انقضى هذا الخيار، ويبقى خيار المجلس إن لم يحصل الافتراق، كما أنّه لو حصل الافتراق قبل الثلاثة سقط خيار المجلس دونه.
وحكي عن السيّد أبي المكارم بن زهرة(١) أنه من حين التفرق. وقد يستظهر ذلك من الشيخ وابن إدريس، لإخبارهما ذلك في خيار الشرط، ودليلهما يقتضي اتحاد هذا الخيار معه في هذا الحكم.
قال في المبسوط: - على ما حكي عنه - الأولى أن يقال: إنّه - يعني خيار الشرط - يثبت من حين التفرّق؛ لأنّ الخيار يدخل إذا ثبت العقد، والعقد لم يثبت قبل التفرق(٢) ، انتهى.
وحكي نحو ذلك عن السرائر(٣) .
أقول: يمكن أن يقال: إنّ قصدهما من ذلك بيان أنّ قصد شارط الخيار هو الشرط، حيث لا خيار لولا الشرط، وهو من حين التفرّق، فيكون معنى قوله: يدخل إذا ثبت العقد، يقصد دخوله اذا ثبت العقد لا الدخول بحكم الشرع.
وعليه، فيرجع كلامهما الى ما في التذكرة(٤) في الاستدلال - لهذا القول - حكايةً عن قائليه: من أنّ الشارط يبغي بالشرط، إثبات ما لولا الشرط لما ثبت، وخيار المجلس ثابت، وإن لم يوجد الشرط فيكون المقصود ما بعده.
____________________
(١) مفتاح الكرامة: المتاجر، في خيار الحيوان ج ٤ ص ٥٥٣ س ٧، غنية النزوع (الجوامع الفقهية: ص ٥٢٥ س ٣٣.
(٢) المبسوط: ج ٢ ص ٨٥.
(٣) السرائر: ج ٢ ص ٢٤٧.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٢٠ س ٢٤.
ولكنّ الإنصاف، أنّ ظاهر العبارة المنقولة خلاف ذلك. وكيف كان فلا إشكال في أصل المسألة. وما يستدلّ به لكون المبدأ حين التفرق ضعيف في الغاية، لأنّا لا نسلّم أنّ الخيار لا يدخل إلاّ بعد ثبوت العقد في حكم الشرع، وقصد الشارط لو كان هو ذلك كان قضيّة بطلان الشرط للجهالة، فيبطل العقد من رأس.
وأمّا ما يقال: من أنّ الخيارين مثلان فلا يجتمعان ففيه منع ذلك، بل هما ماهيّتان مختلفتان، ولو سلّم فمعنى اجتماعهما اجتماع سببيهما، واستنادهما في المدّة المشتركة الى مجموع السببين، وفي الزائد الى ما يختصّ به.
ومن هنا ظهر ما في تعليل الحكم، بأنّه يلزم اجتماع السببين على سببٍ واحدٍ، على أنّه يمكن دفعه: بأنّ الأسباب الشرعيّة معرّفات لا مانع من اجتماع المتعدّد منها في محل واحد.
والحاصل: إنّا لا نسلّم أنّ الإجتماع، وكون المبيع حيواناً أسباب حقيقة لثبوت الخيار، بل هي أمارات شرعيّة، جعلها الشارع معرفةً لحكمه بقاءاً وارتفاعاً.
ويمكن أن يقال - انتصاراً لهذا القول - : بأنّ الشرط، وكون المبيع حيواناً من قبيل الموانع بالنسبة الى اللزوم والعقد قبل التفرّق، لا مقتضى اللزوم فيه، ولا يعقل أن يؤثّر المانع في العدم حال عدم المقتضي، لأنّ وجود المقتضي سابق على عدم المانع، فعدمه حين وجود المانع سابق على وجوده طبعاً. ولا ريب أنّ المسبق يستند المعلول اليه.
ويمكن أن يكون سند الشيخ - في الكلّيّة التي ادّعاها في عبارة المبسوط(١) المنقولة - هو ذلك.
وفيه منع ذلك، لإمكان أن يقال: إن طبيعة العقد مقتضية للّزوم، بحيث ما ثبت الخيار كان لمانع خارجيّ.
____________________
(١) تقدم ص ٤٧٥ رقم (٢)
وهذا هو المناسب لأصالة اللزوم في العقود، التي يمكن دعوى الاتّفاق عليها مطلقاً، أو في الجملة.
وأمّا أصالة عدم حدوث الخيار من حين العقد، وأصالة عدم ارتفاعه من انقضاء الثلاثة أيام من حين العقد، أو المدّة المضروبة للخيار المشروط في ضمن العقد فمدفوعتان بظاهر الأخبار، مضافاً إلى أنّ اولاهما مثبت، لأنّ عدم الحدوث من حين العقد ليس من آثاره الثبوت من حين الافتراق. كما لا يخفى؛ فلا يصلح الاستناد اليهما في جعل المبدأ هو التفرق هنا، وفي خيار الشرط. مضافاً الى أنّه لا معنى للحكم ثبوت خيار الشرط في غير المدّة التي شرط الخيار فيها المتعاقدان.
ودعوى الانصراف في اطلاقها عند شرط الخيار قد عرفت، أنّه على تقدير تسليمه يقتضي بطلان الشرط لجهالته، مع انّه انّما يتمّ في العالم ثبوت خيار المجلس دون الجاهل به.
الرابعة: لا إشكال في أنّ ما يتوسّط بين الأيام من الليلتين على تقدير عدم التلفيق، والليالي الثلاث على تقديره داخل من زمن الخيار، للاستمرار المستفاد من الأخبار، مثل قولهعليهالسلام : (فاذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء)(١) .
فإنّ الظاهر منه أنّ الثلاثة إنّما اعتبرت معرفة للزمان، الذي يستمر فيه الخيار باعتبار مضيتها، وعدمه، حيث أنّه على وجوب الشراء، على مضيّ الثلاثة فيكون عدمه كاشفاً عن عدمه. مضافاً الى أنّ الظاهر من تحديد الأمر القابل للاستمرار بالزمان، أنّ استمراره في الزمان.
فمعنى قوله: (الخيار في الحيوان ثلاثة أيام) أنه مستمر في الثلاثة، وأمّا الليلة الواقعة قبل الثلاثة، وبعد العقد - كما لو فرض وقوعه في الليل - فهي داخلة في زمن الخيار أيضاً، لا أنّ مبدأه - كما عرفت - من حين العقد.
وهل يجب ذلك من الأيام الثلاثة - بناءً على أنّ المراد من اليوم ما يعمّ الملفّق
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب ٣ من ابواب الخيار ح ٩ ج ١٢ ص ٣٥٠.
من قطعةٍ من الليل والنهار، فيجعل آخر الأيام من أجزاء اليوم الثالث هو الجزء الذي لو اضيف اليه ذلك المقدار من الليل كان المجموع نهاراً - أو لا يجب؟
بناء على أنّ المتبادر منه هو البياض المتّصل، أو الأعمّ من الملفّق من قطعتي بياضين، دون غيره، وجهان، والأقرب هو الأخير.
كما أنّ الأقرب - أيضاً - أنّ المراد الأعمّ من الملفّق، لا لأنّه لو لم يعتبر كان مدة الخيار زائداً على الثلاثة التي يفهم من الأخبار حصر الخيار فيها، لأنّ المفهوم من الأخبار - كما عرفت - حصر الخيار في زمان لم يمض فيه ثلاثة أيام؛ وذلك يختلف باختلاف اعتبار اليوم؛ فإن اعتبر الأعمّ من الملفّق كان مضيّه معتبراً، وإن اعتبر المتصل كان مضيه معتبراً، ولا منافاة بين هذا الحصر، وبين دخول الخيار في النصف الواقع قبل الثلاثة، وإنّما المنافاة بينه وبين دخول الخيار في الواقع بعدها، لتحقق المضيّ الذي جعل حدّاً لبقاء الخيار، بل لأنّ المتبادر من الأيام - في التحديدات - الأعمّ من الملفّق، دون خصوص المتّصل.
وأمّا الليلة الواقعة بعد الثلاثة فحالها كحال بعض اليوم الواقع بعدها، في أنّ دخولها في زمن الخيار ينافي كون مضيّ الثلاثة غايةً له.
وأمّا ما ربّما يقال: من أنّ المراد بالأيام الثلاثة ما كانت مع الليالي، لدخول الليلتين أصالةً، فتدخل الثالثة، وإلاّ لاختلفت مفردات الجمع.
فإن أراد به إدخال هذه الليلة فيدفعه: أنّ المراد من اليوم ليس إلاّ حقيقة، وأنّ دخول الليلتين إنّما هو - لما أشرنا من الاستمرار المفهوم من ظاهر أخبار الباب - القائم على طبقه الإجماع.
وإن أراد إدخال الليلة السابقة على الأيام فالتعليل لا وجه له، وإن كان الحكم كما ذكره - لما عرفت - من أنّ دخوله مبنيّ على اتّصال مبدأ الخيار بالعقد.
مسألة: يسقط هذا الخيار بأمور:
منها: اشتراط سقوطه في ضمن العقد، ولا إشكال في ذلك؛ لعموم قولهعليهالسلام : (المؤمنون عند شروطهم). واحتمال مخالفته لمقتضى العقد مدفوع بأن
الخيار مقتضى إطلاق العقد، لا مطلقاً.
وبعبارة اخرى: مقتضى أدلّة ثبوت هذا الخيار كون العقد لو خلّي وطبعه، مؤثّراً في ثبوت الخيار فلا ينافيه السقوط بالاشتراط، مع إمكان دعوى انصرافها الى العقد الغير المقيّد بالشرط، وليس هذا الشرط من قبيل شرط النتيجة، لأنّه عبارة عن شرط حصول المسبّبات الموقوفة بحسب ظاهر الأدلّة على حصول أسباب خاصّة.
وهذا الشرط راجع الى إبداء المانع عن تأثير السبب على الوجه الأوّل، والى منع حصول المقتضي على الوجه الثاني، فلا إشكال فيه من هذه الجهة أيضاً، وإن منعنا صحّة شرط النتيجة.
وكما يصحّ شرط سقوطه بتمامه، كذلك يصحّ شرط سقوط بعضه المعيّن.
ومنها: الإسقاط بعد العقد.
ومنها: التصرف، أي: تصرّف ذي الخيار، ولا إشكال في إسقاطه للخيار في الجملة أيضاً. وإنّما الكلام:
أولاً: في أنّه بجميع أنحائه مسقط، أو يختصّ الحكم بنوع منه(١) .
وثانياً: في أنّ الإسقاط منوط بالكشف عن الرضا، نوعاً أو فعلاً، أو غير منوط بشيءٍ منهما. فالكلام يقع في أمرين:
أما الأول، فتحقيق الكلام فيه: أنّ ما يصدر من ذي الخيار، ويتعلّق بالحيوان قد لا يكون داخلاً في التصرّف، ويكون من قبيل الاستضاءة بنار الغير، والاستظلال بجداره كلمس الحيوان، والنظر اليه.
وفيه النظر الى ما يحرم النظر اليه من الجارية، ولمسها من غير استمتاعٍ، وإن كان حلّها مستنداً إلى الملكية، وقد يكون تصرّفاً.
أمّا الأول: فلا إشكال في عدم إسقاطه الخيار، وفي خروجه عن إطلاق كلمات العلماء، وفي انصراف الأخبار الى غيره، وما اشتمل من الأخبار في مقام التمثيل على
____________________
(١) فيه. (خ).
مثل النظر الى ما يحرم النظر اليه، ولمس الجارية، فلعلّ المراد: الاستمتاع بها قرينة عدهما من أفراد الحدث، الذي علّق سقوط الخيار على إحداثه، ولا ريب في أنّه لا يعدّ ذلك حدثاً عرفاً، بل ولغةً أيضاً.
وأمّا الثاني: فقد صرّح في التذكرة(١) والتحرير(٢) بأنّه يسقط به الخيار مطلقاً، حتى ما كان منها تصرّفاً حقيقياً، مثل الأمر لغلق الباب ، وسقي الماء وعلّل ذلك في مواقع من الأوّل: بأنّه دليل الرضا. وفي هذا العموم إشكال، فأنّ شمول الأخبار لمثل التصرفات الحقيقية التي لا تعدّ عرفاً تصرّفاً في المبيع لا يخلو من إشكال، بل منع، ودلالة مثلها على الرضا باللزوم ممنوعة، مع أن إسقاط الخيار بها منافٍ للحكمة التي ذكروها لشرع الخيار من الإطّلاع على الصفات الخفيّة.
وكيف يمكن الإطّلاع مع ترك التصرّف مطلقاً، مع أنّه لو كان مثل هذه التصرّفات مسقطةً لم يبق مورد للخيار إلاّ نادراً فيلزم أن يكون جعل الخيار الذي شرع لكونه نظرة للمشتري - كما في بعض الأخبار - كاللغو.
وأشكل من ذلك ما سيأتي بيانه - إن شاء اللّه - من سقوط الردّ في خيار العيب بمثل هذه التصرفات، ولو وقعت قبل العلم بالعيب، فأنّ اختصاص أخبار تلك المسألة بغيرها أظهر من أخبار هذه المسألة.
وبالجملة: الذي يقتضيه النظر، هو اختصاص السقوط بما يعدّ عرفاً تصرفاً في المبيع. والضابط، أنّ كلّ تصرفٍ صدر من المشتري في زمان الخيار، وكان ذلك ممّا يحترز عنه العرف ما دام كان الملك غير مستقرّ الملكية عندهم، لكونه معدوداً عندهم من أفراد التصرّف في ملك الغير: كركوب الدابة فراسخ، والاستمتاع، والنظر الى الجارية، وملامستها، ووطئها، وأخذ حافر الدابّة، ونعلها، فهو مسقط للخيار.
____________________
(١) تذكرة الفقهاء: في مسقطات الخيار ج ١ ص ٥١٩ س ٨.
(٢) تحرير الأحكام: في الخيارات ج ٢ - ١ ص ١٦٨ س ٩.
ويدل عليه قولهعليهالسلام ، في صحيحة ابن رئاب : فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً فذلك رضاً منه، ولا شرط له، قال: قيل له: وما الحدث؟ قال : إن لامس، أو قبّل أو نظر منها الى ما كان محرّماً عليه قبل الشراء(١) .
وصحيحة الصفار، كتبت الى أبي محمدعليهالسلام : في الرجل اشترى دابّةً من رجلٍ، فأحدث فيها من أخذ الحافر، أو نعلها، أو ركب ظهرها فراسخ، أله أن يردّها في الثلاثة أيام التي له فيها الخيار، بعد الحدث الذي يحدثها، أو الركوب الذي يركبها؟ فوقّع: اذا أحدث فيها حدثاً، فقد وجب الشراء، إن شاء اللّه(٢) .
وظاهر الأخير، وإن كان اختصاص السقوط بغير مثل الركوب - كما أن ظاهر السؤال عدم كون ركوب الفراسخ حدثاً - فلا يشمله الخبر الأوّل أيضاً. إلاّ أنّ الظاهر بعد التأمل أن تفريق الراوي بل مثل أخذ الحافر، والركوب تفنّن في الكلام.
وأنّ قولهعليهالسلام (إذا أحدث فيها حدثاً) جواب عن كلا المسألتين - أعني السقوط بما فرضه الراوي حدثاً، وما عدّه في قباله - ولا أقلّ من الاحتمال؛ فالخبر الأوّل سليم عن المعارض، مضافاً الى إمكان دعوى الإجماع، على أنّ مثل الركوب فراسخ مسقط للخيار، فلو كان للخبر ظهور في احتمال اختصاص السقوط بغير الركوب لما كان العمل به جائزاً، كيف وهو ممنوع
ثم اعلم، أنّ ما شك دخوله في الضابط، فالمرجع فيه العرف، فإن ارتفع وإلاّ فأصالة بقاء الخيار سليم عن المعارض.
وأمّا كلمات العلماء، فلا يحضرني ما أرجع إليه، والمنقول من عبائرهم فليس مطابقاً لما حكيناه عن التذكرة بالصراحة.
فعن المقنعة أنّ هلاك الحيوان في الثلاثة من البائع، إلاّ أن يحدث فيه المبتاع حدثاً يدلّ على الرضا(٣) .
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب ٤ من ابواب الخيار ح ١ ج ١٢ ص ٣٥٠.
(٢) وسائل الشيعة: ب ٤ من ابواب الخيار ح ٢ ج ١٢ س ٣٥١.
(٣) المقنعة: ص ٥٩٢.
وحكي عنه التمثيل لذلك في موضع آخر: بأن ينظر من الأمة الى ما يحرم لغير المالك(١) .
وعن الغنية في موضعين منها: استثناء إحداث الحدث الدال على الرضا عن ثبوت الخيار(٢) .
وعن السرائر - بعد الحكم بالخيار في الحيوان الى ثلاثة أيام - : هذا إذا لم يحدث في هذه المدّة حدثاً يدلّ على الرضا(٣) .
وعن موضع آخر: إذا لم يتصرّف فيه تصرّفاً يؤذن بالرضا في العادة(٤) .
وهذه العبائر - كما ترى - مثل الأخبار في عدم الشمول لمثل الأمر بالسقي، وتمثيل الأوّل بالنظر محمول على ما حملنا عليه الأخبار، من قصد الاستمتاع.
وبالجملة: كلّما عدّ في نظر العرف تصرّفاً في المبيع يكون مسقطاً، ولو فرضنا مخالفة المشهور لما ذكرنا، وحكمهم بأنّ كلّ تصرفٍ لغويّ يكون مسقطاً فذلك لا يوهن به ما اخترناه، للعلم بأنّ دليلهم في تعيين الضابط ليس الأخبار التي قد أشرنا الى بعضها، وهي - كما عرفت - لا دلالة فيها على اعتبار غير ما ذكرناه في السقوط.
وأمّا الأمر الثاني: فتحقيق الكلام فيه يتوقف على التكلّم في الأخبار.
فنقول: إن الظاهر أنّ المراد من الرضا ليس الرضا الحاصل عند العقد الثاني غالباً، بعد الفراغ منه، ولو في مدّة يسيرة، فأنّ إسقاط الخيار بذلك، ولو بشرط اقترانه بما يكشف عنه يوجب عدم حدوث الخيار في أغلب أفراد البيع.
ويشهد له - أيضاً - رواية عبد اللّه بن الحسن بن زيد بن عليّ بن الحسينعليهالسلام ، عن أبيه، عن جعفرعليهالسلام ، عن أبيهعليهالسلام ، قال: قال رسول
____________________
(١) المقنعة: ص ٥٩٣.
(٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) ص ٥٢٦ س ٢ و س ١٣.
(٣) السرائر: ج ٢ ص ٢٤١.
(٤) السرائر: ج ٢ ص ٢٤٧.
اللّهصلىاللهعليهوآله في رجلٍ اشترى عبداً لشرط الى ثلاثة أيام، فمات العبد في الشرط، قال: يستحلف باللّه ما رضيته، ثم هو بريء من الضمان(١) . فأنّ المراد من الرضا هو الالتزام، وإلاّ فالرضا بالملكية - كما عرفت - حاصل بعد العقد، ولو في زمان يسير، فلا حاجة الى الحلف، فالمراد الالتزام قلباً لو أنشأه بفعلٍ أو قول.
وكيف كان قولهعليهالسلام فذلك رضاً، يحتمل وجوهاً:
أحدها: أن يكون تنزيلاً مراعياً للحدث منزلة الرضا، ومقتضاه سقوط الخيارية، حتى مع العلم بأنّه لا يكون مع الرضا.
ثانيها: أن يكون إخباراً عن الواقع، والمراد منه: التنزيل العرفي، لا بمعنى تقييد القضية بقولنا: عرفاً، بل بمعنى كون بناء الأخبار على تنزيل المخبر نفسه منزلة العرف.
ثالثها: أن يكون إخباراً عن الواقع، ويكون المراد: أنّ الإحداث متى تحقّق فهو رضاً - بناءً على أنّ مطلق الكاشف عن الالتزام القلبي إلتزام - وإن لم يقصد به إنشاء الالتزام.
رابعها: أن يكون إخباراً عن الواقع، ويكون المراد: أنّه متى تحقّق الحدث فالرضا محقّق، ويكون الاتحاد، الذي هو مفهوم القضية، كناية عن ذلك، ومصحّح دعوى الاتحاد: إمّا هو الدلالة - أعني كون الحدث دالاً على الرضا - وإمّا كون الرضا غالباً سبباً لحدوث الحدث، وإمّا مجرد مصاحبة الحدث للرضا.
وأوجه المصحّحات هو الأوّل، حيث أنّ اتحاد الدّال مع مدلوله حال الكشف عن المدلول إذا لوحظ بهذه الحيثيّة أظهر من اتحاد المسبب مع سببه، أو اتحاد المتصاحبين مع الآخر.
وإذا عرفت ذلك، فمقتضى أوّل الوجوه المحتملة في الفقرة المذكورة أن يكون هو الجواب للشرط. وعليه - كما مرّ الإشارة إليه - لا فرق بين أنواعه من حيث الاقتران
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب ٥ من ابواب الخيار ح ٤ ج ١٢ ص ٣٥٢.
بالرضا، وعدم الاقتران به.
وأمّا على باقي الوجوه، فلا يخفى أنّه لا يصحّ أن يكون جواباً للشرط، لأنّ الأخبار بهذه المعاني ليس غرضاً لهعليهالسلام ، فهي - حينئذٍ - إمّا حكمة للجواب، نظير كون الرضا حكمةً لكون الافتراق مسقطاً في خيار المجلس، وحكم هذا كما لو كان هو الجواب، ضرورة أنّ الحكمة لا تفيد موضوع الحكم، فلا فرق في الحدث بين المقرون فيه بالرضا، وبين غيره، وإمّا علّة له. وهذا الوجه يختلف حكمه باعتبار المعاني السابقة.
فإن قلنا: إنّ المراد: هو التنزيل العرفي، فإن اريد التنزيل في الحكم - أعني عدم سلطنة المشتري معه على الردّ - كان مقتضاه السقوط في كلّ ما هو بحكم الالتزام عرفاً؛ وإن لم يكن كاشفاً عن الرضا، لاقترانه بما يعلم معه عدم الرضا كوطء الجارية، وركوب الدابة فراسخ وأمثالهما فإنّ من لاحظ عمل العرف يقطع بأنّ مثل هذه التصرفات لا يصلح معها رّد البيع، ولا يكون المتصرّف مسلّطاً عليه عندهم، وإن علم صدورها من غير التزام، فضلاً عن الشكّ في ذلك، أو ظهور كونه مع الرضا. والإحداث - بمقتضى ما اخترنا في معناه - كلّه من هذا القبيل. وعليه لا تكون القضيّة غالبيّةً.
وإن اريد منه التنزيل في الموضوع أمكن أنّ ما لا يكون له ظهور في الالتزام - لاقترانه بما يدلّ على عدم الالتزام - خارج عن العلّة، فيخرج بذلك عن عموم الإحداث، لاقتضاء العلّة قصر الحكم على موردها.
وإن قلنا: إن الحدث الالتزام حقيقة - لأنّ كلّ ما دلّ على الالتزام قلباً إلتزام - وإن لم يقصد به إنشاؤه، فإن كان الحكم عليه بذلك بملاحظة نوعه كان مقتضاه سقوط الخيار بكلّ كاشفٍ نوعيّ ولو لم يكن تصرفاً، وعدم الاعتبار بما قرن بما يعلم معه عدم الرضا والالتزام فأنّه ليس التزاماً - حينئذٍ - وإن كان بملاحظة شخص التصرف اعتبر دلالة الشخص عليه، وحيث لم يعلم الاكتفاء بالظنّ كان المناط حصول العلم بالرضا.
ومثل هذه الصورة في الحكم، إن قلنا: إنّ المراد: اتحاد الحدث مع الرضا، وهو كناية عن وجوده، فإن اعتبر ذلك بملاحظة النوع دخل في الحكم كلّ كاشفٍ عن الرضا، وخرج من أفراد التصرف ما يعلم - لوجود القرينة - عدم حصول الرضا معه وإن اعتبر بملاحظة شخص التصرّف كان المناط العلم بالرضا، ثم إن قضية هذا الوجه كون المسقط الرضا القلبي، وعدم العبرة بالتصرف إلاّ من حيث الكشف.
غاية الأمر، أنّه على التقدير الأوّل اعتبر الكشف النوعي، والظهور في إثبات مناط السقوط - وحينئذ - يشكل الأمر من حيث أنّ قضية ذلك، كون الرضا اذا حصل مسقطاً وإن لم يعلم به، وكون حصول العلم به كافياً في الحكم بالسقوط، من أيّ طريقٍ حصل عليه، فيجب على ذي الخيار الوفاء بالعقد، إذ الالتزام قلباً - وإن لم يحدث أمر مظهر للرضا - والتزام الأصحاب بذلك في غاية الإشكال، فإن ثبت إجماع وجب التقييد بوجود الكاشف عن الرضا، والالتزام بأنّ للكاشف دخلاً في رفع الخيار
الثالث من الخيارات - خيار الشرط
بسم اللّه الرحمن الرحيم
وبه نستعين
الحمد للّه رب العالمين. والصلاة على محمد وآله الطاهرين. ولعنة اللّه على اعدائهم ومن أبغضهم وعاندهم أجمعين الى يوم الدين.
والمراد منه: المسبّب عن شرطه في متن العقد. وهو ممّا لا خلاف فيه عندنا. وحكاية الاجماع بلغت الاستفاضة.
والأصل فيه قبل الإجماع عموم الأخبار(١) المسوّغة للشرط، وأخبار خاصّة(٢) ، لعلّه تأتي الإشارة الى بعضها في المسائل الآتية - إن شاء اللّه -.
والإشكال في الاستدلال بالطائفة الاولى: بأنّ الشرط مخالف لمقتضى العقد، وهو اللزوم فيسري الأخبار الخاصّة، لمعارضتها - ما استثني - مخالفة الكتاب والسنّة من الشروط في الأخبار العامّة لا يلتفت اليه بعد الإجماع وسيأتي المراد من مخالفة الكتاب والسنّة في باب الشروط.
وبالجملة: الكلام هنا في أحكامه بعد الفراغ من صحّته في الجملة، وهو يتمّ برسم مسائل:
الاولى: لا فرق عندنا بين اتّصال زمان الخيار بالعقد وانفصاله، لعموم أدلّة الشرط. وعن الشافعيّ(٣) : منع الأخير؛ مستدلاً بأنّه يلزم صيرورة اللازم جائزاً بعد تحقّق اللزوم.
والجواب: منع بطلان التالي، مع أنّه كما عن التذكرة(٤) منتقض ببعض الخيارات الآتية كخيار الرؤية.
نعم، يجب أن تكون مدّة الخيار مضبوطةً من حيث المبدأ، والمنتهى. فلا يصحّ شرطه الى قدوم الحاجّ، أو الحصاد، أو الدباس لأنّه غرر، والبيع يصير به غرراً في بعض المواقع، لأنّه حقّ ماليّ يقع عليه الصلح، ويبذل بإزائه المال، ويختلف بوجوده وعدمه فيه المبيع.
ولذا يقع التشاحّ في مقدارٍ يسيرٍ منه، فاشتبه الجهل به الجهل بمقدار المكيل والموزون، في كون المعاوضة معه - سواء كان عوضاً، أو كان ملكه شرطاً في ضمنها - غرريّاً، فيكون الشرط منه فاسداً، على القول بأنّ الغرر في غير البيع مبطل. والبيع
____________________
(١ و ٢) وسائل الشيعة: ب ٦ و ٧ من أبواب الخيار ج ١٢ ص ٣٥٣ - ٣٥٤.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٢٠ س ٣٨.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٢٠ س ٣٨.
حتى مع القول بأنّه في غير البيع لا يفسد فاسداً، لأنّه يسري الغرر من الشرط اليه، فلا يبتني الفساد على القول بإبطال الغرر في غير البيع، وأنّ الشرط الفاسد مفسد للعقد.
ومن هنا علم، أنّه لا حاجة الى الاستدلال بأنّ اشتراط المدّة المجهولة مخالف للكتاب والسنة، لأنّه غرر، إن أريد منه كون الشرط في نفسه فاسداً لكونه غرراً، وإن اريد منه أنّه لا يستلزمه الغرر في البيع يكون مخالفاً للكتاب والسنة.
ففيه: أنّ الشرط أنّه لا يكون ما أبطل الشرط المخالف شاملاً لمثل ذلك، لأنّ المراد منه: ما كان بنفسه مخالفاً، لا ما كان صحّته ملازماً لوقوع مخالفة للكتاب.
ثم اعلم، أنّه قد حقّق في محلّه، أنّ المناط في ابطال الغرر كون المعاملة التي تطرّق فيها الجهل بنوعها معه غرريّةً، وإن لم يكن كذلك في شخص المقام فلا عبرة بمسامحة المتعاقدين في بعض الموارد، وإقدامهم على الغرر.
وممّا يؤيّد ذلك، بل يدلّ عليه، النهي عن السلف الى الدباس والحصاد، مع إقدام الناس عليه كثيراً.
لا يقال: لا نسلّم أنّ اشتراط المدّة المجهولة غرر، لأنّ الجهل بأصل الخيار أعظم من الجهل بحدوده، ولا ريب أنّ البيع مع الشكّ في ثبوت بعض الخيارات لا يكون باطلاً ولا يعدّ غرريّاً.
لأنّا نقول: دخول الخيار في العقد بحكم الشارع غير دخوله فيه بجعل المتعاقدين، فأنّ الجهل بالأوّل راجع الى الجهل بصفات البيع، وحدوث الطوارئ الخارجة مع العلم بصفات المبيع، والجهل بالثاني راجع الى الجهل بما وقع العقد عليه، وكون الثاني موجباً للغرر، ولا يلزم فيه كون الأوّل كذلك.
فإن قلت: المعاملة إذا لم تؤمّن من ترتّب الضرر عليها خطر، سواء كان منشأ ذلك الجهل بما وقع العقد عليه، أو اعتبر فيه، أو غير ذلك، ومع الجهل بثبوت الخيار تكون المعاملة خطراً.
قلت: ليس كلّ غررٍ منهيّاً عنه، بل هو ما كان مستنداً الى البيع لو خلي بطبعه،
مع قطع النظر عن الخارج. ثمّ إنّه لا فرق في بطلان العقد مع عدم تعيين المدّة، بين أن يطلق الشرط من غير تصريح بالمدّة، وبين التصريح بها من غير تعيين أصلاً، وبين التعيين بأمرٍ غير مضبوطٍ كقدوم الحاج لأنّ البيع في جميع هذه الصور غرر.
إلاّ أنّه حكي عن المقنعة(١) والانتصار(٢) والخلاف(٣) وجواهر القاضي(٤) والحلبي(٥) : أنّه يكون البيع صحيحاً، ومدّة الشرط ثلاثة أيام. بل نسب ذلك الى المشهور بين المتقدّمين، وعن الانتصار وتالييه الاجماع عليه. وعن الخلاف نسبته الى أخبار الفرقة.
وهذه الحكاية بمنزلة أخبارٍ مرسلة، فهي مؤيّدة بالاجماعات السابقة، والشهرة المحكيّة كافية في إثبات الصحّة. مضافاً الى قولهعليهالسلام : (الشرط في الحيوان ثلاثة للمشتري اشترط أو لم يشترط) دلّ بمفهومه على أنّ الشرط في غير الحيوان ثلاثة على تقدير الاشتراط. والمراد ينبغي أن يكون شرطه مطلقاً، لا مع تعيين المدّة، ضرورة أنّه لا يختص الصحّة مع التعيين بالثلاثة، بل أيّ عددٍ اعتبر في العقد كان الشرط صحيحاً.
وفيه: أنّ ظاهر المنطوق ثبوت الخيار في الثلاثة على تقديري شرط الخيار وعدمه، والمفهوم عدم ثبوت الخيار في الثلاثة على التقديرين، فهو يدلّ على أنّه ثابت في الثلاثة على تقدير الشرط، وليس فيه دلالة على اختصاص الثبوت على تقدير الشرط بالثلاثة، فيصير موجباً لحمل الكلام على شرط الخيار مطلقاً، دون شرط الخيار ثلاثة أيام، لعدم إمكان الأخذ بظاهر الاختصاص على هذا التقدير.
ويرد على ما قبله: أنّ المرسل المحكيّ عن الشيخ لم يوجد منه أثر في كتب
____________________
(١) المقنعة: كتاب البيع ص ٥٩٢.
(٢) الانتصار: ص ٢١١.
(٣) الخلاف: ج ٣ ص ٢٠ مسألة ٢٥.
(٤) جواهر الفقه: كتاب البيع ص ٥٤ مسألة ١٩٤.
(٥) الكافي في الفقه: ص ٣٥٣.
الأخبار، فلعلّ نسبته الى الأخبار مبنيّ على اجتهاده، فلا يعلم في المقام خبر مرسل ينجبر ضعفه سنداً أو دلالة بما مرّ من الأجماع.
والحاصل: أنّ احتمال استناد الشيخ في إرساله الى اجتهاده في دلالة الأخبار يمنع عن الاستناد الى إرساله، واحتمال استناد المجمعين الى دلالاتٍ اجتهاديّةٍ في الأخبار مانع عن تأييد مرسل الشيخ، أو انجباره باجماعهم، لأنّ انجبار المرسل سنداً، أو دلالةً بالإجماع إنّما يصحّ إذا كان مسند المجمعين هو المرسل.
فلو فرضنا أنّ هنا مرسلاً قابلاً للإنجبار لم يصحّ هنا دعوى انجباره بما ذكر.
وممّا يؤيّد كون إرسال الشيخ مبنيّاً على الاجتهاد، اختياره في المبسوط(١) القول بالبطلان كما حكاه عنه السيد في الرياض(٢) .
وأمّا الاجماعات، فهي مع مصير المتأخرين الى خلافها، لا يمكن المصير معها الى مخالفته القاعدة المتّفق عليها، خصوصاً مع كون أغلب إجماعات السيّد في الغنية، والقاضي في الجوهر مأخوذة من إجماعات السيّد في الانتصار كما قيل. وإجماعه هنا مع قوّة احتمال بنيانه على الاجتهاد - كما عرفت من مخالفة الشيخ الذي هو في أطراف آخر عصره له - موهون بمخالفته له في غير الانتصار كما حكاه عنه في الرياض(٣) .
وربّما ينتصر للقائلين بالصحّة: بأنّه ليس في الأدلّة ما يخالف ذلك، لأنّ الغرر مندفع بتحديد الشرع، وإن لم يعلم به المتعاقدان كخيار الحيوان الذي لا إشكال في صحّة العقد مع الجهل به، أو بمدّته.
وفيه: أنّ الغرر لا يندفع بتحديد الشرع ما لم يكن رافعاً لمناطه، وهو جهل المتعاقدين الموجب لعدم الأمن من الوقوع في الضرر.
____________________
(١) المبسوط: ج ٢ ص ٨٣.
(٢) رياض المسائل: في خيار الشرط ج ١ ص ٥٢٤ س ٣٢.
(٣) رياض المسائل: ج ١ ص ٥٢٤ س ٣٢.
وأمّا صحّة البيع في الجهل بخيار الحيوان - فقد عرفت - أنّه لعدم دخول مثل ذلك في الغرر المنهيّ عنه، وقياس ما نحن فيه عليه لا وجه له، بعد كون ما وقع في ضمن العقد محمولاً.
وبالجملة: دعوى كون التحديد الشرعيّ مخرجاً للمعاملة عن عنوان الغرر، مع بقاء مناطه الذي هو الجهل الموجب لعدم أمن المتعاقدين من الوقوع في الضرر، لا يخلو عن ضعف.
نعم، لو قلنا: إنّ حكمة بطلان الغرر آثاره التشاحّ والنزاع كان تحديد الشرع موجباً لارتفاع حكمة البطلان، فكان الالتزام بالصحّة والتخصيص في إطلاق النهي الموجب للفساد مع قيام الدليل المخصّص تعيّناً.
فتلخّص أنّ الأقوى ما اختاره المتأخرون من فساد البيع. وربّما يحكى هنا التفصيل بين الشرط والعقد به بطلان الأول دون الثاني. وقد عرفت، أنّه لا وجه له، لأنّ الغرر في الشرط يوجب كون العقد غرريّاً، ولعلّه يأتي تحقيق ذلك - إن شاء اللّه تعالى - في باب الشروط.
مسألة: مبدأ هذا الخيار عند الاطلاق حين الفراغ من العقد، لأنّه المتبادر من الاطلاق، وقد عرفت البحث في خلاف الشيخ في ما سبق، فلا نعيده.
مسألة: كما يجوز جعل هذا الخيار للمتعاقدين، كذلك يجوز جعله لأجنبيّ واحداً أو أكثر، ويجوز لكلّ واحدٍ ممن له الخيار - على تقدير التعدّد - الفسخ والإجازة، ولكنّ مع التعارض يقدّم الفسخ، لأنّ فائده الخيار تأثيره، فلو لم يؤثّر لغي الشرط اللازم الذي أمر المتعاقدان بالوفاء به فالتردّد في ذلك، أو الجزم بعدمه ليس في محلّه. وهل يجب على الأجنبيّ رعاية أصلح الأمرين بحال المشروط له؟
قد يقال: نعم، لأنّه أمين. وهو مشكل، لأنّ هذا التعليل لا يلائم ما قالوه: إنّه بحكم لا توكيل، فالمناط مراعاة لفظ الشرط، فإن كان مقتضياً لذلك - ولولا
انصرافه - كان هو المبيع، وإلاّ كان إطلاقه محكماً.
والحاصل: أنّ المراد من جعل الخيار للأجنبيّ، الذي هو عنوان هذه المسألة تسليطه على أيّ الأمرين شأنه من إبقاء العقد ودفعه، على أن يكون مستقلاً في ذلك، لا جعل الخيار لمن شرط الخيار للأجنبيّ، وشرط كون الأجنبي وكيلاً عنه، ولذا لا يؤثر فسخه، فليس هنا شيء أو ثمن عليه الأجنبيّ، فيجب عليه مراعاة المصلحة لكونه أجنبيّاً.
ثم إنّه لا إشكال في أنّه لا ينتقل هذا الخيار الى وارث الأجنبيّ إن قلنا: إنّه مجرد ولاية التصرّف في العقد، وكذلك الأمر إن قلنا: إنّه حقّ مالي كسائر الخيارات وكالخيار المشروط للمتعاقدين، لأنّ الظاهر أنّ الخيار جعل لشخص الأجنبيّ منحيث هو مشخصه، نظير الوقف على شخص. وسيأتي توضيحه في أحكام الخيار إن شاء اللّه تعالى.
وفي توقف صحة هذا الشرط على قبول الأجنبي، وعدمه وجهان:
من عدم وجوب الوفاء بالشرط، ومن أنّ حصول ذلك للأجنبيّ بفعل الغير قهر عليه مناف لسلطنته على نفسه، ولم أعثر هنا على كلامٍ لأحد.
ثم إنّه قال في التذكرة : لو باع العبد و شرط الخيار للعبد صحّ البيع ، و الشرط عندنا لأنّ العبد بمنزلة الأجنبيّ(١) .
وفي القواعد: لو جعل الخيار لعبد أحدهما فالخيار لمولاه(٢) .
وفيه أيضاً: لو كان العبد لأجنبيّ لم يملك مولاه، ولا يتوقف على رضاه اذا لم يمنع حقاً للمولى(٣) .
قلت: إن كان العلّة في كون الخيار لمولى العبد عدم قابلية العبد لملك الخيار لم يكن فرق بين عبد أحد البيّعين، وعبد الأجنبيّ، مع أنّ مقتضى ذلك فساد
____________________
(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٢١ س ٢١.
(٢) و (٣) قواعد الأحكام: الجزء الاول ص ١٤٤ س ١.
الشرط، لا لكونه للمولى، لأنّه غير مقصود.
وإن كان معناه عدم تأثير لفظ العبد فسخاً وإجازة ما لم يقترن برضا المولى - لأنّه لا يقدر على شيء - لم يكن فرق بينهما أيضاً.
والتحقيق: أنّ العبد إن منعنا ملكه للحقوق - كما أنّه لا يملك الأحوال - فالشرط فاسد. وإن قلنا: إنّه يملك الحق فالظاهر توقف تأثير لفظه على إذن المولى.
ولا يتوهّم، أنّ هذا يرجع الى كون الخيار للمولى، إذ لا أثر لفسخ المولى، وأنّما إذنه شرط في تأثير المؤثر، وهو فسخ العبد.
هذا إن كان المقصود من جعل الخيار للعبد سلطنته على الفسخ في الجملة، ولو في حال إذن المولى.
وإن كان القصد سلطنته عليه مطلقاً - ولو من دون إذن مولاه - ففيه إشكال. والأقوى في النظر عاجلاً فساد الشرط، لأنّ العبد « لا يقدر على شيءٍ وهو كلّ على مولاه »(١) نطق بذلك الكتاب العزيز والقرآن المجيد.
مسألة: يجوز لكلّ منهما اشتراط الاستئمار، والمراد: أن يشترط أحدهما على صاحبه أن يأتمر المشروط عليه بأمر الأجنبيّ إذا استأمره المشروط له في أمر العقد، أو يأمره ابتداءً، فأن أمر الأجنبيّ بالاجازة لم يكن لأحدهما الفسخ، لأنّ فعله معلّق بمقتضى جعلهما على الأمر به، ولم يحصل. ولأنّ معنى الائتمار الالتزام بأمره، ومعناه الالتزام بالعقد عند الأمر بإجازته، وإن أمر بالفسخ، فإن لم يكن المشروط له طالباً له فالظاهر أنّه لا يجب، وإن طلبه فكذلك، لأنّ معنى ائتماره بأمره ليس إنشاء الفسخ، بل الرضا به، والالتزام به اذا أجازه المشروط له، ومقتضى ذلك سلطنة المشروط له على الفسخ، لا وجوب الفسخ على المشروط عليه.
والحاصل: أنّ المستأمر هو المشروط له، فالأمر بالفسخ متوجّه إليه، لا إلى المشروط عليه، فليس معنى الائتمار المشروط عليه بهذا الأمر إلاّ الرضا به، والالتزام
____________________
(١) النحل: ٧٦.
بفعل المشروط.
ولو فرض أنّه شرط أحدهما على صاحبه استئماره الأجنبي فالمفهوم منه عرفاً ليس - أيضاً - إنشاؤه الفسخ، ولا سلطنة عليه دون المشروط له، بل الرضا به والالتزام به إذ اختاره المشروط له.
ومن هنا علم، أنّ المشروط عليه ليس له السلطنة على الفسخ في الصورتين. وممّا ذكر، ظهر الفرق بين هذه المسألة، وجعل الخيار للأجنبيّ، لأنّ الخيار هنا للمشروط له، وأمر الأجنبي بالفسخ شرط لحصوله، فالأجنبيّ هنا كالمشروط له في المسألة السابقة في أنّه لا يكون فسخه مؤثّراً. ويجب تعيين مدّة الاستئمار، لأنّ بدونه يكون الشرط غرراً.
فرع
إذا أمره الأجنبيّ بالفسخ ابتداءً، وكان الشرط الائتمار بأمره بعد الاستئمار فهل للمشروط له الفسخ؟ وجهان:
من أنّ الشرط غير حاصل، ومن أنّ الغرض من شرط الاستئمار - وهو حصول الأمر - وهو حاصل.
والحاصل: أنّ شرط الاستئمار ليس مقصوداً بذاته، وإنّما اعتبر لكونه سبباً لحصول الأمر، فالشرط حقيقةً هو الالتزام بأمر الأجنبي.
نعم، لو علم تعلّق غرض بالاستئمار غير تحصّل الأمر كان عدم حصول الخيار بالأمر ابتداءً واضحاً.
فرع
لو شرط أحدهما على صاحبه قبل الفسخ، اذا أمره الأجنبي فالظاهر وجوب ذلك عليه، بل الظاهر أنّه لو لم يفعل أجبره الحاكم. ولكنّ هذه المسألة من مسائل الشرط. والحاصل: أنّ مسألة الاستئمار المعدودة من مسائل شرط الخيار، حقيقتها
اشتراط أحدهما على صاحبه خياره، بعد أن يأمره الأجنبيّ بالفسخ، أو يأمر صاحبه به.
وتوهّم التلفيق في الانشاء، لأنّ الشرط هو الخيار على تقدير أمر الأجنبيّ ليس في محلّه، لأنّ الأمر هنا معرّف للزمان، فافهم.
مسألة: من أفراد شرط الخيار الشرط بعد ردّ الثمن، ويعبّر عن البيع المشروط فيه: بيع الخيار، وهو بيع الشيء مع اشتراط البائع لنفسه على المشتري الخيار في يده، بأن يردّ الثمن، ويرتجع المبيع. وحاصله شرط السلطنة على الارتجاع بعد تحقّق الردّ، وهو جائز.
وعن التذكرة(١) ، الاجماع عليه، ويدلّ عليه قبله عمومات لزوم الشرط، وجملة من الأخبار الواردة في خصوص المسألة.
منها: موثقة إسحاق بن عمار، قال: حدّثني من سمع أبا عبد اللّه ، سأله رجل وأنا عنده، فقال: رجل مسلم احتاج الى بيع داره، فمشى الى أخيه، فقال له: أبيعك داري هذه، ويكون لك أحبّ إليّ من أن يكون لغيرك، على شرط لي أنّي اذا جئتك بثمنها الى سنةٍ أن تردّها عليّ قال: لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها ردّها عليه، قلت: أرأيت لو كان للدار غلّة لمن تكون الغلة؟ فقال: الغلّة للمشتري، ألا ترى أنّها لو أحرقت كانت من ماله(٢) الخبر.
قوله: اذا جئتك بثمنها الى سنةٍ، ظاهره الابتدائي، وإن كان مطلقاً إلاّ أنّه يمكن دعوى كون المراد من ذلك المجيء بالثمن، على أن يكون المشتري الملازم للفسخ الفعلي، نظراً الى أن الغرض من ذلك ليس إلاّ ارتجاع المبيع.
قوله: تردّها عليّ، يحتمل أن يكون المراد هو الردّ الخارجيّ، ويكون المعنى أنّي اذا جئتك بالثمن تردّ المبيع، ولا يكون لك - حينئذٍ - كلام. وحاصل الشرط - حينئذٍ -
____________________
(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٢١ س ٣٩.
(٢) وسائل الشيعة: ب ٨ من ابواب الخيار ح ١ ج ١٢ ص ٣٥٥. مع اختلاف في بعض الالفاظ.
سلطنة البائع على الفسخ الفعلى، وأن يكون المراد هو الإقالة على أن يكون الردّ الخارجيّ كنايةً عن ملزومه الذي هو الإقالة. فالشرط - حينئذٍ - إقالة المشتري عند إقالة البيع. وهذا مخالف لظاهر اللفظ.
ويحتمل - بعيداً - أن يكون المراد من الردّ: الردّ الحكميّ، وهو اخراجه من ماله وإدخاله في مال البائع، وهذا يرجع الى شرط معاوضةٍ جديدة، وهو - مع بعده في نفسه - لا يلائم قوله: اذا جئتك بالثمن، لأنّه ظاهر في الفسخ الفعليّ.
وبالجملة: التمسّك بالرواية لفروض المسألة مشكل.
ومنها: رواية معاوية بن ميسرة، قال: سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد اللّه: عن رجل باع داراً له من رجل، وكان بينه وبين الذي اشترى الدار خلطة، فشرط أنّك إن أتيتني بمالي بين ثلاث سنين فالدار دارك، فأتاه بماله، قال: له شرطه.(١) . الخبر.
قوله: إن أتيتني بمالي هو نظير قوله في الرواية السابقة: إن جئتك بالثمن.
قوله: فالدار دارك، يحتمل أن يكون المراد ظاهره، وهو أنّ الدار لك عند الإتيان بالثمن، فيرجع الى شرط حصول الفسخ بعد الردّ، وأن يكون كناية عن الالتزام بردّ الدار، وعدم السلطنة على منعه عنها، فيكون الشرط سلطنة البائع على الفسخ بالردّ.
وهذا، وإن كان مخالفاً للظاهر، لا يبعد أن تحمل الرواية عليه، نظراً الى ظهور كون السؤال في هذه الأخبار عن حكمه عن المعاملة المتعارفة بين الناس، وهو البيع بشرط خيار البائع، وسلطنته على ردّ الثمن، وارتجاع المبيع.
ومنها: رواية أبي الجارود عن أبي جعفرعليهالسلام : قال: إن بعت رجلاً على شرط، فإن أتاك بمالك، وإلاّ فالمبيع لك(٢) .
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب ٨ من ابواب الخيار ح ٣ ج ١٢ ص ٣٥٥.
(٢) وسائل الشيعة: ب ٧ من ابواب الخيار ح ٢ ج ١٢ ص ٣٥٤.
أقول: يحتمل أن يكون المراد من قوله: (بعت رجلاً) الشراء - بناءً على أنّ لفظ البيع يطلق على المعنى الأعمّ من الشراء والبيع - فيكون المراد من الشرط شرط ردّ المبيع عند ردّ الثمن، ويكون المراد من البيع في قوله: فالبيع لك: المبيع، فيكون كناية عن لزومه، وعدم سلطنة البائع على ردّ الثمن وارتجاع المبيع، وحينئذٍ تكون الرواية من أدلّة ما نحن فيه، أو أن يكون المراد من قوله: بعت معناه الحقيقي، ويكون المراد من الشرط، شرط تعجيل الثمن مثلاً، ويكون المراد من البيع في قوله: فالبيع لك العقد - أي - اختياره إبقاءً ودفعاً لك، فلا دخل له بمسألتنا.
والثاني وإن كان أقرب من الأول - لعدم التجوّز في لفظ البيع - إلاّ أنّ إرادة العقد من البيع بعيد. مع أنّ الظاهر أنّ قولهعليهالسلام : فإن أتاك بمالك هو تعبير عن الشرط، وكون المراد منه، المال الذي ثبت كونه له بهذا البيع، حتى يكون المراد من إتيانه التعجيل في الاقباض بعيد.
مع أنّ في التعبير بالاتيان، ودخل الدفع والاقباض نوع إيماء إلى أنّ الشرط هو الردّ، لا تعجيل الثمن، ومع ذلك وضوح المسألة أشدّ من أن نحتاج في إثباتها الى هذا الخبر.
ومنها: رواية سعيد بن يسار في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّهعليهالسلام : إنّا نخالط اناساً من أهل السواد وغيرهم، ونبيعهم ونربح عليهم في العشرة اثني عشر، وثلاثة عشر، ونؤجّل ذلك فيما بيننا وبينهم السنة، ونحوها، ويكتب لنا رجل منهم على داره أو أرضه بذلك المال، الذي فيه الفضل الذي أخذ منّا شراءً بأنه باع وقبض الثمن، فعنده إن هو جاء بالمال الى وقتٍ بيننا وبينهم أن نردّ عليه الشراء، فإن جاء هذا الوقت، ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا، فما ترى في الشراء؟ فقال: أرى أنّه لك إذا لم يفعله، وإن جاء بالمال للوقت فتردّ عليه(١) .
أقول: قوله (فنعده) الظاهر أنّه ليس المراد من مجرّد الوعد بعد العقد، ولا قبله
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب ٧ من ابواب الخيار ح ١ ج ١٢ ص ٣٥٤ مع تفاوت يسير.
على وجهٍ لا يقع البيع على ذلك الشرط، بل المراد التباني على ذلك، على أن يكون البيع مشروطاً بذلك، والردّ المشروط هنا، ومجرّد المال يراد بهما ما مرّ في رواية إسحاق بن عمار.
وهذه الرواية تدلّ على جواز اشتراط ردّ بدل الثمن على تقدير تلفه، فأنّ الثمن - هنا - لكونه في الذمّة يتلف بمجرّد وقوع البيع صحيحاً، فاشتراط الردّ حقيقةً إشتراط الردّ ما يصلح أن يكون أداءً لذلك على تقدير بقائه وهو قبله. ولعلّه يأتي لذلك بيان أوضح من ذلك في بعض المسائل الآتية إن شاء اللّه تعالى.
ثمّ اعلم، أنّ المراد من الردّ: هو تسليط المشتري على الثمن، ودفع البائع منعه عن تصرفه فيه بعد إحضاره إيّاه عند المشتري، وبعبارة اخرى إحضار له عند المشتري بهذا العنوان.
وأمّا قبض المشتري وحصوله تحت يده، فليس معتبراً، وهذا المعنى هو الظاهر من الأخبار. ثم إنّ الردّ بهذا المعنى، قد يجعل شرطاً لحصول الخيار أو مبدأ لحدوثه.
وقد يجعل قيداً للفسخ الذي جعل السلطنة عليه شرطاً في العقد، بمعنى أن يكون الشرط سلطنة المشتري على الفسخ المسبوق بالردّ.
وقد يجعل متعلّق الخيار المشروط على أن يكون فسخاً فعليّاً. وقد عرفت أنّ الأظهر من الأخبار هذا المعنى. وقد يكون الشرط انفساخ البيع عند الردّ كما هو محتمل الرواية الثانية، أو إقالة المشتري كما هو محتمل الرواية الاولى والأخيرة، والشرط بهذين المعنيين خارج عن مسألة شرط الخيار.
وفي صحة الأوّل منهما إشكال، فأنّ ذلك راجع الى شرط حصول ما يتوقّف على أسباب خاصّةٍ بدون حصول تلك الأسباب، فيبتنى صحة الشرط - حينئذٍ - على أن لا يكون التوقّف دائماً كما في مثل توقّف الزوجية على عقد النكاح، إذ على هذا التقدير يكون نفس الشرط في العقد سبباً لحصوله.
والحاصل: إن كان المعهود من الشرع حصوله بامور، وتوقّفه عليها في الجملة كتوقف الملكية على البيع - مثلاً - صحّ الشرط. وإن كان حصوله بها، وتوقّفه عليها
مطلقاً - بحيث لا يصلح قيام الشرط مقام تلك الأسباب بعد ملاحظة أدلّة وجوب الوفاء، بحيث كان الشرط - حينئذ - مخالفاً للمشروع كاشتراط الزوجية - فهو باطل، ولكن يكفي في الحكم بالصحة الجهل بكونه من القسم الثاني، لأنّ مخالفة الشرع - حينئذٍ - غير معلومةٍ، والأصل عدمها، فيكون داخلاً في (المؤمنون) وخارجاً عن الاستثناء.
وتوهّم أنّه لا مجرى للأصل، لأنّ المعتبر دخوله في المستثنى منه، لا خروجه من المستثنى. والأصل لا يثبت الأوّل. يدفعه أنّ المستثنى منه ليس له عنوان، وجري يخالف الأصل، بل هو الغير المخالف. والأصل ثبّت هذا المفهوم، لأنّه عين مجراه.
فإن قلت: أصل التوقّف معلوم فلا معنى للأصل.
قلنا: التوقّف على وجهٍ يخالف شرط حصوله بدونها غير معلوم، والأصل عدمه، وأصالة عدمه على وجهٍ غير مخالف لا أثر له هنا حتى يعارض به أصالة عدم مشروعيّة على الوجه المخالف.
فإن قلت: هذا الأصل معارض بأصالة عدم حصول الانفساخ بعد الردّ.
قلنا: الشكّ في حصول الفسخ مسبّب عن الشك في صحة الشرط، وإذ قد أحرزنا - ولو بواسطة الأصل - صحته. فلا يبقى شكّ في حصوله.
والحاصل: أنّ أصالة عدم المخالفة حاكم على أصالة عدم تحقّق الانفساخ.
وسيأتي - إن شاء اللّه تعالى وتقدّس - ولي في صحّة التمسك بالأصل إشكال، لأنّ الوصف العنواني - وإن كان مطابقاً للأصل - يكون اتّصاف الموضوع به مشكوكاً غير مسبوق بالتعين، لأنّ حدوثه على أحد الوجهين - أعني متّصفاً بالمخالفة، وعدمها - مشكوك، وليس هذا من قبيل استصحاب طهارة المصلّي، لأنّه راجع الى استصحاب كونه طاهراً، وبعبارة اخرى راجع الى استصحاب اتّحاده مع عنوان الظاهر، وهو مسبوق باليقين.
والحاصل: أنّ إثبات الموضوع بإحراز بعض أجزائه بالوجدان، والبعض الآخر بالأصل، لا يخلو من شوب إشكال، لإمكان أن يقال: إنّ الأصل على وجهٍ يترتّب
عليه المقصود من الاصول المثبتة؛ إذا لم يكن أصل الاتصاف له حال سابقة يقينيّة، فتأمل. ولعلّ يأتي بعض الكلام في ذلك في باب الشروط، وبعض المسائل الآتية إن شاء اللّه تعالى وتقدّس.
مسائل
الاولى: الظاهر أنّ الخيار ثابت في المدّة المضروبة، وإن لم يدفع المشتري الثمن الى البائع، لأنّ اشتراط الردّ في ثبوت الخيار إنّما هو على تقدير القبض، فالشرط ثبوت الخيار في المدة إذا حصل الثمن عند المشتري، سواء كان بالردّ، أو بحصوله عنده من حين العقد.
ويحتمل أن يقال: بعدم الخيار نظراً الى الظاهر من حيث أنه مشروط بالردّ، الذي يتوقّف على القبض فالشرط هو الخيار على تقدير القبض والردّ، وهو بعيد غاية البعد، لأنّ الغرض من هذه المعاملة التوصّل الى الثمن، عاجلاً مع القدرة على استرداد المبيع آجلاً، وهو ينافي الشرط على هذا الوجه. إلاّ أن يقال:
إنّ ذلك لا يوجب كون الشرط هو الخيار المشروط لحصول الثمن عند المشتري، سواء كان بالردّ بعد القبض، أو بثبوته عنده لعدم القبض، بل مقتضاه اشتراط التعجيل في أداء الثمن، والخيار على تقدير القبض والردّ، فيكون شرط الخيار منحلاً الى شرطين:
أحدهما: تعجيل المشتري وأداء الثمن، والخيار بعد الردّ، وحينئذ، فإن لم يعجّل في القبض يكون له خيار تخلّف الشرط، وإن عجّل فله بعد الردّ خيار الشرط.
وتظهر الثمرة في انقضاء المدّة، فأنّه على تقدير كون الخيار على تقدير عدم القبض مستنداً الى شرط الخيار يلزم العقد اذا لم يفسخ في المدة، وعلى تقدير كونه لتخلّف الشرط يكون باقياً، إن لم نقل بفورية هذا الخيار.
وفي إقباض المشتري وعدم قبض البائع، فأنّه على الأوّل يكون الخيار ثابتاً، لأنّ شرط الخيار حصول الثمن عند المشتري، وهو حاصل وإن كان بسبب عدم قبض
البائع. وعلى الثاني لا خيار، لأنّ الشرط، وهو إقباض المشتري حاصل، وإنما الامتناع من البائع، فتأمّل.
الثانية: الردّ الذي اعتبر شرطاً لثبوت الخيار، إن اريد منه ردّ خصوص المقبوض فلا إشكال في أنّه لا يحصل الخيار بردّ بدله، سواء كان المقبوض ثمناً، أو أداءً للمضمون في ذمّة المشتري.
وإن أريد منه ردّه على تقدير بقائه، وردّ بدله على تقدير عدم بقائه فلا إشكال في ثبوت الخيار مطلقاً بردّ العين، وردّ بدله على تقدير تلفه. وفي صحّة تعليق الخيار على الرد الأعم من رد العين ورد البدل، حتى في صورة بقاء المقبوض في ملك البائع إشكال.
أمّا إذا كان المقبوض عين الثمن فالظاهر، لأنّه مخالف لمقتضى الفسخ لغة وشرعاً، لأنّ مقتضاه رجوع كلّ من العوضين الى محلّه قبل العقد، والرجوع الى البدل إنّما هو عند تغيير العين، فشرط الخيار المعلّق على الردّ بهدا المعنى مخالف للمشروع، وكذلك الأمر اذا كان المقبوض أداءً لما كان مضموناً في ذمّة المشتري، لأن ذلك المضمون بعد القبض متحد مع المقبوض، فهو - حينئذٍ - عين الثمن. وقد كان مقتضى الفسخ رجوع نفس العوض الى محلّه الأصليّ، مع بقائه في ملك البائع.
ويمكن أن يفرّق بين الصورتين، بأنّ مقتضى الفسخ اذا كان مضموناً في ذمّة المشتري رجوع ذلك الى المشتري، ولمّا كان ذلك حاصلاً عند البائع لم يكن مقتضاه إلاّ رجوعه الى المشتري بوصف حصوله عند البائع، وهذا لا يقتضي إلاّ كونه مضموناً بعد الفسخ في ذمة البائع.
وأمّا تعيّنه في المقبوض قبل الفسخ فالمفروض انه لم يعتبر في العقد، والقبض الواقع بعده لا يقتضي إلاّ تعيّن ما في ذمّة المشتري في المقبوض.
ويرد عليه: أنّ ملك البائع لهذا المقبوض أنّما هو من حيث اتّحاده في المثمن المعتبر في عقد البيع، فاذا رجع ما هو متّحد معه الى المشتري يقتضي الفسخ.
فلا معنى لبقاء ذلك في ملك البائع.
وبعبارة اخرى: القبض الواقع بعد العقد اقتضى نقل ما في الذمّة الى الخارج، فالمقبوض عين الثمن، فهو راجع بعد الفسخ الى المشتري، لأنّه قضيّة العينيّة.
والحاصل: أنّ القبض فيما اذا كان الثمن مضموناً في الذمة ليس معاوضة من البائع والمشتري لما في الذمّة بالموجود الخارجي، حتى يقال: إنّ قضية هذه المعاوضة تلف الثمن والفسخ على تقدير التلف لا يقتضي إلاّ الرجوع الى البدل، والبدل نسبته الى المقبوض كنسبته الى غيره، بل هو نقل لما في الذمّة منها الى الخارج.
فالموجود الخارجي بعد القبض عين الثمن، فيرجع الى المشتري بعد الفسخ كما هو قضيّة العينيّة، والمسألة بعد محتاجة الى التأمل.
وفي اشتراط ردّ القيمة في المثلي على تقدير التلف، أو بالعكس إشكال. فأنّ معنى هذا الشرط وحقيقته كون القيمة المردودة ملكاً للمشتري بدلاً عن الثمن التالف بعد الفسخ، ورجوع المبيع الى البائع.
وهذا، وإن لم يكن منافياً لقضية الفسخ، لأنّه لا يقتضي إلاّ رجوع البدل، وليس مقتضاه تعيين المثل بدلاً عن المثلي لا يخلو من إشكال، لأن تعيين القيمة بدلاً عن المثلي مخالف لتعيين الشارع وحكمه ببدلية المثل. إلاّ أن يقال:
إنّ تعيين الشارع ليس على وجه الكلّيّة، بحيث لا يقبل التغيير ولو بالشرط، وفيه تأمل.
أو يقال: إنّ غرض المتعاقدين في تعيين البدل ليس بدليّة ذلك عن العين. بحيث لا يتوسّط بينهما دخول المثل في الذمة آناً ما، وفراغ الذمّة بالمدفوع على أن يكون أداءً عنه. وإنّما الغرض عدم استحقاق المشتري بعد الفسخ غير ما دفعه اليه البائع، فالشرط - حينئذٍ - بمنزلة شرط وفاء ما في الذمّة بغير جنسه.
وفيه: أنّ المتّبع(١) منطوق كلام المتعاقدين، وعموم الغرض له ولغيره لا يؤثّر في
____________________
(١) « المنع خ ».
صحّة الشرط على غير الوجه الذي اعتبراه، ووقع قصدهما إليه.
نعم لو شرطا كون المدفوع وفاءً لما يستقرّ بعد الفسخ في الذمّة، بحيث يكون حصوله في يد المشتري بعد الفسخ بمنزلة إيفاء البائع لما في الذمّة، كان الأقوى صحّة الشرط، ولكنّك قد عرفت أنّ حقيقة الشرط المذكور بدليّة القيمة عن التالف، ورجوعه الى المشتري بعد الفسخ من حيث أنّه بدل عنه، إلاّ أن يقال:
إنّ عموم الغرض قرينة على أنّ المراد من البدليّة أعمّ من بدليّة ذلك عن التالف بلا واسطة، والبدلية عنه بتوسط المثل، فاذا كان الشرط له وجه صحةٍ لزم الوفاء به.
ونقول هنا: إنّ الفسخ يوجب استقرار المثل في الذمّة، والشرط يقتضي كون حصول القيمة في يد المشتري وفاءً، فالمثل يستقرّ آناً ما ويسقط بالمدفوع.
هذا غاية ما يسع لي من المقال في دفع الإشكال، ولكنّ التأمّل بعد له مجال.
وإن أطلق الردّ، وكان الثمن عيناً فالذي رجّحه شيخنا - قدس اللّه نفسه الزكية - في المكاسب(١) ظهور ردّ نفس الثمن، واستظهر من إطلاق حاشية الشرائع(٢) والدروس:(٣) : أنّ الاطلاق لا يحمل على العين، وهو عندي غير بعيد.
وإن أطلق الردّ، وكان الثمن كلّيّاً في ذمة البائع فلا شبهة في أنّ الردّ يراد فيه ردّ ما يصدق عليه ذلك الكلّيّ، سواء قلنا: بأنّ المدفوع عينه، أو قلنا: إنّ ما في الذمّة بعد صحّة البيع تلف على المشتري بأداء المبيع، الذي ملكه بالبيع، ويكون ما يدفعه البائع بعد الفسخ بدلاً عنه.
وإن أطلق، وكان الثمن كلّيّاً في ذمّة المشتري فالظاهر أنّ الاطلاق لا يحمل على العين المقبوضة أداء للكليّ، وهل يراد من الأعمّ من ردّ البدل حتى في صورة بقاء المقبوض، فيفسد - بناء على ما مرّ - أو ردّه المقبوض على تقدير بقائه، والبدل على
____________________
(١) المكاسب: الخيارات ص ٢٣٠ س ٢٣.
(٢) ليس عندنا حاشية الشرائع.
(٣) الدروس الشرعيّة: كتاب الخيار ص ٣٦٠.
تقدير تلفه، فيصحّ ؟ فيه إشكال. والمتيقّن هو الأخير.
قلت: الظاهر أنّ متعلّق الردّ المعلّق عليه الخيار هو الثمن الذي وقع عليه العقد، ومقتضى إطلاقه كفاية الردّ بغير المقبوض، لصدق ردّ الكلّيّ، كما أنّ قضية يصدق، يصدق على إقباض فردٍ منه، أيّ فردٍ كان.
ولكن يمكن أن يقال: إنّ هذا الاطلاق ينصرف الى ردّ المقبوض ما دام باقياً، وردّ غيره إن تلف، نظراً الى ما نشاهد من حال العرف أنّ البائع منهم اذا أراد ارتجاع المبيع لا يرى لنفسه استحقاق تبديل المقبوض بغيره، وأنّه لو فعل ذلك وطالبه المشتري بالمقبوض لا يعدّ ذلك منه مطالبةً لغير ما يستحقّه، ولا عبرة(١) في تنقيح ذلك، لأنّه انما كان يطالب البائع مع بقاء المقبوض بردّه، لأنّه إن كان الشرط فاسداً لفساد البيع فليس له إمساك المقبوض لإرادة الاطلاق.
وإن كان واقعاً على الوجه الصحيح فلا يستحقّ الفسخ إلاّ مع ردّه، وعلى تقدير صحته إطلاق الردّ فالأصل عند الشك فيه، وفي إرادة ردّه - ما دام باقياً - يقتضي العمل بالتقييد، لأنّ الأصل عدم حدوث الخيار بردّ البدل، وعدم تأثير فسخه في ردّ المعاملة.
الثالثة: مقتضى تعلّق الخيار بالردّ، وتقيّد الفسخ بسبق الردّ - كما في بعض صور الاشتراط - عدم كون الردّ فسخاً. ضرورة أنّ الخيار على الأوّل موقوف على حصوله، وتأثير الفسخ موقوف على الخيار، وأنّ المسلّط عليه على الثاني هو الفسخ بعد الردّ.
ولعلّ هذا مستند ما ادّعي ظهوره من كلمات الأصحاب(٢) . وحكي عن الدروس(٣) النصّ عليه، من أن الرّدّ لا يكون فسخاً، حيث أنّ المعنون في كلماتهم هو شرط الخيار بعد الردّ، وربّما يعلّل ذلك بعدم دلالة الردّ على الفسخ. نعم، يدلّ
____________________
(١) ثمرة (خ).
(٢) الدروس الشرعيّة: ص ٣٦٠.
(٣) جواهر الكلام: ح ٢٣ ص ٣٧.
على إرادته. والإرادة غير المراد.
قلت: لا أرى فرقاً بين دفع البائع السلعة الى المشتري في بيع المعاطات وردّ المشترى لها اليه اذا قصد إبطال المعاوضة الفعلية، فكما أنّ الأوّل إنشاء للبيع كذلك الثاني إنشاء بفسخه.
نعم، الفرق بينهما أنّ البائع يقصد من الإيصال الى المشتري تمليكه، وإخراجه عن يده مقدّمة للإيصال المقصود به التمليك، وأنّ الأخراج عن ملكه لا يكون مقصوداً له، وأنّما يحصل بحصول التمليك، والمشتري يقصد من إخراجه عن يده اخراجه عن ماله، الذي هو حقيقة إبطال العقد المعبّر عنه بالفسخ، والإيصال الى المشتري غير مقصود منه إلاّ تحقّق الخروج الظاهر، الذي يقصد به الخروج عن ملكه.
وإذا كان الردّ هناك كذلك، فلا أظنّك تدّعي الفرق بين الردّ في المقامين سلّمنا عدم قصد الإنشاء، لكنّا ندّعي دلالته على الرضا بملكيّة المردود اليه للمردود، وهذا المقدار كافٍ في حصول الفسخ، لما سيأتي في باب الفسخ، مضافاً الى أنّ الأخبار - كما عرفت - كلّها ناطقة بكفاية الردّ في حصوله.
لا يقال: إنّ موردها شرط خيار الفسخ بالردّ، لا شرط الخيار بعد الردّ كما هو مفروض الكلام، فأنّ المدّعى قابليّة الردّ لحصول الفسخ به في حدّ ذاته. وهذا لا يفرّق فيه مفروض الكلام عن مورد الأخبار.
نعم، الفرق بينهما من وجهٍ آخر، وهو عدم حصول الخيار قبل الردّ - هنا - لعدم شرطه، وحصوله هناك لاطلاق اشتراطه في متن العقد، وهذا هو الموجب للفرق بينهما كما عرفت.
الرابعة: يسقط هذا الخيار بامور:
منها: الإسقاط، ولا إشكال فيه إذا كان بعد الردّ، وقبل الفسخ، وأمّا قبل الردّ ففيه إشكال، فأنّه إسقاط لما لم يجب، وهو منجزاً - غير معقول إنشاء عن جدّ وتأثير. ضرورة أنّ إسقاط الحقّ فرع وجوده.
ولذا منع العلاّمة(١) في التذكرة عن إسقاط خياري الحيوان والشرط قبل التفرق، إن قلنا: إنّ مبدأهما التفرّق، ومن هذا القبيل إسقاط خيار الغبن قبل تحقّق سببه، وهو العلم بالعيب، وإسقاط ضمان الودعيّ المفرّط قبل حصول التلف، وبراءة البائع من العيوب.
ولذلك أشكل في جامع المقاصد(٢) على المصنّف، حيث حكم بسقوط ضمان الودعيّ بالاسقاط بعد حصره المسقط في الاستئمان الجديد، بأنّ هذا ليس استئماناً جديداً، والاسقاط قبل تحقّق الضمان غير جائز.
وقال في المسالك - في هذه المسألة أو نظيرها كلاماً. محصّله - : انّ الضمان معنى متحقّق قبل حصول التلف دائرة استقرار البدل في ذمّة الضامن بعد التلف، وحاصله حدوث حقّ للمالك على الضامن يوجب الردّ اليه مع بقاء المال، وردّ بدله مع التلف(٣) .
وقالوا - في مسألة براءة البائع من العيب - : بأنّ ذلك ليس إسقاطاً، أنّما هو إبداء للمانع عن تأثير سبب الخيار في حدوثه، وهو وجود العيب.
وكذلك يمكن أن يقال بمثل ذلك في إسقاط خيار الغبن قبل حدوث السبب: بأنّ الاسقاط تقبّل للضرر المحتمل، فهو يمنع عن تأثير السبب في حدوثه بعد تحققه، وهو العلم بالغبن.
وبالجملة: الحكم بحصول السقوط هنا من غير إدخال الاسقاط الى بعض ما ذكر، أو ما يشبهه في غاية الإشكال.
[ ومجرّد السلطنة على الردّ لا تؤثر في ذلك، ويمكن أن يكون الوجه فيما نحن فيه
____________________
(١) المكاسب: الخيارات ص ٢٣٠ س آخر.
(٢) جامع المقاصد: ج ٦ ص ٤٨.
(٣) مسالك الافهام: ج ١ ص ٣١١ س ٤.
رجوع إسقاط الخيار هنا إلى اسقاط الشرط، فأنّ الشرط في ضمن العقد يوجب كون المشروط له مالكاً لشرطه على المشروط عليه ، وهو - هنا - السلطنة على الفسخ من غير اعتبار رضا المشروط عليه، معلقاً على الردّ - كما هنا - أو مطلقاً كما في مطلق خيار الشرط. وحينئذٍ، فالفرق بين خيار الحيوان - بناءً على كون مبدئه التفرّق - وبين ما نحن فيه، ظاهر. وأمّا خيار الشرط، فلا فرق بينه، وبين ما نحن فيه.
أو يقال: إنّ شرط السلطنة على الخيار بعد الردّ يوجب ملك الردّ، وكونه من حقوقه على المشروط عليه. وهذا الحقّ - ما دام باقياً - يوجب حدوث الخيار بعد تحقق الردّ، فإسقاط الخيار إسقاط لهذا الحقّ.
ولعلّ الى هذا نظر من فرّق بين مطلق خيار الشرط، وهذا القسم منه، فتأمل فيه، فأنّه لا يخلو من إشكال. فأني لا أتعقّل معنى لملكية الفاعل المختار لفعله الى سلطنةٍ على المعاوضة عليه، وأخذ الاجرة.
والوجه الأوّل أيضاً لا يخلو من إشكال، لأنّ معنى ملكية الشرط الى تحقق أثره، وهو إن كان ملكية شيء فلا يقبل الاسقاط كاشتراط مال العبد في بيعه، وإن كان من الحقوق فيصحّ إسقاطه كاشتراط عتق العبد في ضمن البيع، فأنّه يقبل الاسقاط - من حيث هو - مع قطع النظر عن الحقوق. وآخر كما سيأتي الكلام فيه في محلّه إن شاء اللّه تعالى.
فالأولى أن يقال في ما نحن فيه: إنّ شرط الخيار معلقاً على أمر يوجب حدوث حقّ للمشروط له في أحد العوضين، وهو موجب لحدوثٍ بسببه الخيار عند حصول المعلّق عليه.
ولذلك، لا يجوز لمن ليس له الخيار التصرّفات المنافية له قبل حلوله. فتأمّل في الاستشهاد، والاسقاط راجع الى إسقاط هذا الحقّ. وهذا إذا أسقط لا يتحقّق ما يبتني تحقّقه على بقاء ذلك الى زمان حدوث المعلّق عليه.
ومنها: انقضاء مدّة الخيار، سواء لم يتحقّق الردّ أو تحقق، ولم يفسخ الى أن تقضى المدّة. ومن أفراد عدم الردّ، الرّد بغير الجنس. وأمّا ردّ المعيب إن كان الشرط ردّ
البدل على تقدير التلف فهو ردّ، إلاّ أن للمشروط عليه إبداله.
ويمكن أن يقال: إنّه ليس، بردّ، نظراً الى أن انصراف الاطلاق الى ردّ الصحيح يوجب كون الشرط ردّ الصحيح، وهو غير حاصل. إلا أن يقال:
إنّ ذلك بمنزلة شرط مستقلّ من المشروط عليه الخيار على المشرط له، وهو ردّ الصحيح، وأثره ليس إلاّ السلطنة على الإبدال، حتى بعد الفسخ. في ذلك تأمّل، فأنّ الغرض من تعليق الخيار على الردّ هو كون الثمن تحت يد المشروط عليه فعلاً. وأن لا يبقى حقّه عند البائع بعد فسخ البيع ، وهذا يقتضي - نفسياً - للرد بالصحّة ](١) وليس هذا من قبيل وصف الصحّة في العوضين المنصرف اليه الاطلاق، لإمكان أن يقال:
إنّه بمنزلة الشرط وليس من المقوّمات التي ينتفي المعارض بانتفائها.
ومنها: التصرّف - بناءً على عموم إسقاطه للخيار إلاّ ما استثني - كتصرّف المغبون قبل العلم بالغبن، لاستفادة العموم من عموم العلّة في قوله، فذلك رضا، ولا شرط له.
وتحقيق الكلام: أنّ التصرّف، إمّا أن يكون بعد الردّ أو قبله، وعلى التقديرين، إمّا أن يكون الثمن كلّيّاً في ذمّة المشتري، وإمّا أن يكون عيناً خارجيّاً.
أمّا اذا كان التصرّف قبل الردّ وكان الثمن كليّاً فالظاهر أنّه لا يسقط الخيار به، لأنّ اشتراط الردّ راجع الى شرط أحد الأمرين من ردّ عين المقبوض، وبدله على تقدير التلف، فهو غير منافٍ لبقاء الخيار، فلا دلالة فيه على الرضا باللزوم.
وإذا كان قبل الردّ، وكان الثمن عيناً، فإن كان الشرط ردّه صريحاً فيسقط الخيار بالتصرف الموجب لتلفه، أو نقله نقلاً لازماً، ويلحق به التصرف في الثمن الكلّيّ إذا شرط ردّ المقبوض، إلاّ أن السقوط هنا يمكن أن يكون لانتفاء شرط ثبوت الخيار، فلو عاد اليه الملك بعد النقل يفسخ تلك المعاملة، أو بناقلٍ فيمكن
____________________
(١) ما بين المعقوفتين قيل بزيادته في الأصل، كما في الحاشية فراجع.
القول بثبوت الخيار لعود إمكان الشرط.
ويحتمل العدم نظراً الى ثبوت اللزوم. والأوجه، الفرق بين فسخ المعاملة فيكون ثابتاً، والعود بالنقل فلا يكون، لعدم إمكان تأثير السبب السابق على البيع الخياريّ في ملك الثمن إلاّ برفع ما بينه وبين الفسخ من المعاوضات، فتأمّل.
وأمّا الغير الموجب للنقل، فإن قلنا بعموم ما دلّ على أنّ التصرّف مسقط لخيار الشرط - نظراً الى عموم التعليل - كان الخيار ساقطاً به، وحينئذ يسقط البحث في مسألة العود بالفسخ، والناقل الجديد في التصرف الناقل، ويلحق به صورة اشتراط الردّ مطلقاً اذا كان الثمن عيناً، بناء على ظهوره في ردّ تلك العين.
ومن هنا يعلم حال التصرف - بعد الردّ في العين - المشروط ردّه بالنصّ أو الاطلاق سواء كان الثمن كلّيّاً أو عينياً، وهو أن التصرّف أنّما ثبت إسقاطه الخيار حيث يعقل الاسقاط، وهو قبل الردّ غير معقول.
ولا دليل على أنّ التصرّف - كالاسقاط القوليّ - مسقط للشرط الموجب للخيار، أو الحقّ الحادث بسبب قبل ثبوت الخيار، كما وجّهنا تأثير الاسقاط قبل الردّ.
والحاصل: أنّه لا دلالة للتصرّف على إسقاط الشرط، ولا على إسقاط الحقّ الحادث بسببه غير الخيار، ولا دليل على كونه مؤثّراً في ذلك قهراً على المتصرّف، إلاّ أن يقال:
والفرق بين المقام، وخياري الحيوان والشرط، بأنّ المشروط له - هنا - مالك للخيار قبل الردّ، ولو من حيث ملكه للردّ الموجب له، فله إسقاطه بخلاف الخيارين، إن اريد منه كون ذلك موجباً لفعليّة الخيار، ففيه منع ظاهر. إلاّ أن يقال: لا معنى لكون البائع بالخيار إلاّ كونه بحيث متى أراد الفسخ فسخ.
وهذا المعنى حاصل في هذا المقام، لأنّه يصحّ أن يقال: إنّ البائع متى أراد أن يفسخ كان له ذلك. والسرّ فيه كون السبب باختياره.
وفيه: أنّ الخيار ليس مجرد التمكّن من الفسخ، بل هو ملك الفسخ والسلطنة عليه، وهذا المعنى غير حاصلٍ، وإن كان تحصيله اختيارياً لكون سببه اختيارياً، ولو
كان اختيارية السبب كافياً في تحقّقه خرج السبب عن السببيّة.
وإن اريد منه كفاية ذلك في صحة الاسقاط - وهو بعيد عن العبارة - ففيه أنّ التوقّف عقليّ لا شرعيّ حتى يقبل تنزيل غير الشرط منزلته، بدليل. وهو مع ذلك مفقود.
هذا كلّه مع إمكان أن يقال: إنّ السبب في حدوث الخيارين - أيضاً - اختياري، خصوصاً - بناءً على مختار المشهور - كفاية حصول الافتراق ولو من أحدهما.
ويمكن القول: بأنّ الإسقاط قبل حدوث الخيار يؤثّر السقوط حين حدوثه، ولكنّه يحتاج الى دليلٍ مفقودٍ هنا، وأنّ القول به في مسألة الغبن لكونه التزاماً بالضرر، وهنا وجوه اخر للتفصّي عن الإشكال:
أحدها: أنّ لذي الخيار قبل حدوثه ضعيف من فسخ الخيار يلزمه قضية تعليقيّة - وهي ما نحن فيه - إن ردّ فله الخيار، وهذا الحقّ ملازم للخيار، وجوداً وعدماً، بل هو من قبيل المقتضي لثبوته في محلّه، فمتى سقط هذا الحق بمسقط كالاسقاط - مثلاً - منع ذلك عن حدوث الخيار، والاسقاط قبل الردّ راجع الى إسقاط ذلك الحقّ.
وفيه منع ذلك، ومنع كون إسقاط الخيار إسقاطاً له، إن اريد منه كون ذلك قصد منشأ السقوط. كيف، وربّما لا يكون شاعراً بذلك كما لو جهل بثبوته وكذلك لو اريد كونه أثراً له تعبّداً، بل المنع هنا أشدّ.
ثانيها: أنّ إسقاط الخيار هنا راجع الى إسقاط الشرط، ولا ريب أنّ المشروط له إسقاط شرطه، إن كان من قبيل الحقوق.
ويمكن المناقشة فيه: بأنّه اريد من السلطنة على إسقاط الشرط إسقاط الحقّ الذي كان سبباً عن الشرط.
ففيه: أنّه ما لم يحدث غير قابل للاسقاط، وإن اريد أنّ المشروط له مالك لحقّ على المشروط عليه بواسطة شرطه، وهو موجب لحدوث الشرط في محلّه، ففيه منع ثبوته، بل الحقّ الثابت بالشرط منحصر في ما تعلّق به الالتزام. إلاّ أن يقال:
إن كون الخيار بعد الرد، الذي وقع عليه الالتزام من حقوق المشروط له، وله إسقاطه.
والحاصل: أنّ المدلول المطابقي للشرط الذي اعتبر في متن العقد - ولو كان قضية تعليقية من حقوق المشروط له، وله إسقاطه، وإسقاط الخيار قبل الردّ - لا يقصد منه إلاّ رفع هذه القضية.
ثالثها: أنّ الشرط ينحل الى أمرين:
أحدهما: السلطنة على الردّ.
والثاني: الفسخ بعده. وإسقاط الخيار إسقاط للسلطنة على الردّ.
والحاصل: أن معنى شرط الخيار معلّقاً على الرّد جعل السلطنة على الردّ، والخيار بعده. وفيه منع ذلك، بل الشرط هو الخيار متعلقاً، مع أن المراد من السلطنة على الرد، إن كان إلزام القبول على المشروط عليه.
ففيه: أنّ ذلك خلاف ما عرفت من أنّ المراد من الردّ: هو تمكين المشروط عليه قبل أو لم يقبل، وإن كان مجرّد التمكين، وكون هذا حقّاً لا يتحقق معناه.
ومنها: التصرف فيما اذا كان الشرط ردّ المقبوض من المشتري - سواء كان هو الثمن أداءً له، بناءً على عموم ما دلّ على أنّ التصرف مسقط لغير خيار الحيوان من أفراد الخيار، وهو إذا كان بعد الردّ - لا إشكال فيه.
وأمّا اذا وقع قبله ففيه إشكال، لإمكان أن يقال: إنّ معنى قولهعليهالسلام : (إن أحدث حدثاً فذلك رضا منه). ولا شرط كون الحدث واقعاً للشرط، ولا دليل على أنه واقع له.
وفيه أنّ المفهوم من القضية أنّ الحدث سبب لعدم الشرط، لكونه رضا، وهو أعمّ من الدفع والرفع.
غاية الأمر، أنّ مورد الصحيحة من قبيل الرفع، وهو لا تخصيص، مع أن الدفع أهون من الرفع، فالتصرف أولى به من الرفع.
وحكي عن الأردبيلي(١) : أنّه منع من كون التصرف مسقطاً، معلّلاً، بأنّ المدار في هذا الخيار عليه، لأنّه شرّع لانتفاع البائع، بالثمن، فلو سقط الخيار سقطت الفائدة.
ولعلّ التعليل قرينة على أنّ المراد غير محلّ الكلام، وهو ما اذا لم يكن الشرط ردّ عين المقبوض؛ لأنّ الخيار مع شرط ردّ العين معلوم أنّه لم يشرّع للانتفاع بالثمن مع ثبوت الخيار.
وعن العلاّمة الطباطبائي(٢) : الردّ عليه، بأنّ التصرف المسقط ما وقع في زمان الخيار، ولا خيار إلاّ بعد الردّ، وما علّل به عدم السقوط لا ينافي السقوط بعد الردّ. وقد عرفت عموم النصّ لما قبل الردّ.
وقد يجاب عنه: بأنّ المستفاد من عموم النصّ والفتوى كون التصرف مسقطاً في كلّ مقام يصحّ إسقاطه بالقول، فأنّ تأثير الاسقاط في السقوط أنّما كان لأجل كونه إسقاطاً للشرط، وهي القضية التعليقية بناءً على أوسط الوجوه، وهو الوجه الثاني من وجوه التفصّي، والتصرف لا يكون إسقاطاً، ودلالته على الرضا بعدم الشرط لا يوجب إسقاطه به من حيث أنّه شرط.
ولذا، لو فرضنا أنّ الشرط غير الخيار، لا يمكن أن يقال: إنّ التصرف الدالّ على الرضا بعدم الشرط مسقط له إذ لا دليل عليه، فالأوجه ما مرّ من عموم النصّ لذلك في نفسه، ولو لم نقل بأنّ الاسقاط يؤثّر، ولكنّ هذه المناقشة لا تتوجّه على المجيب لبنائه على أنّ الاسقاط مسقط، لكون الاختيار في السبب كافياً في صحة الاسقاط.
وقد يناقش(٣) في كلام السيّد العلاّمة: بأنّ الخيار مستمرّ من حين العقد، لأنّ كونه من حين الردّ مستلزم لجهالة مبدئه، ولحكم العرف بذلك، ولأنّه الظاهر من
____________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان: ج ٨ ص ٤١٣.
(٢) المكاسب: الخيارات ص ٢٣١ س ٧.
(٣) جواهر الكلام : ج ٢٣ ص ٤٠.
كثيرٍ من الأصحاب، حيث أنّهم تمسّكوا في ردّ قول الشيخ(١) -رحمهالله - بحدوث الملك بعد الخيار ببعض أخبار هذه المسألة الدالّة على أنّ علّة المبيع للمشتري.
وفيه: أنّ الجهل لا يمنع اذا لم يستلزم الغرر، وهو هنا مفقود اذا كان زمان السلطنة على الردّ والفسخ محدوداً وأمّا العرف فحكمهم تابع لجعل المتعاقدين، مع أنّه لو فرض تخلّفه عنه لا يؤثّر شيئاً، ضرورة أنّ الخيار تابع للشرط على أيّ وجهٍ أخذ في متن العقد.
وأمّا تمسّك الأصحاب بهذه الأخبار، فلعلّه مبنيّ على عموم دعوى الشيخ(٢) بحدوث الملك بعد الخيار، للخيار المنفصل عن العقد، فلابدّ من التأمّل في كلامه.
ثم إنّ مقتضى تقييد عنوان المسألة، بما إذا كان الشرط ردّ عين الثمن عدم سقوط الخيار، التصرف في الثمن بعد ردّه اذا كان الشرط ردّ ما يعمّ البدل، وأولى منه ما اذا كان الردّ بالبدل من المثل والقيمة ثم تصرف فيه، ولكنّ الحكم بعدم السقوط لا يخلو من إشكال، إذا تلف المبيع فهو من مال المشتري؛ لقولهعليهالسلام - في ذيل موثقة إسحاق السابقة بعد حكمهعليهالسلام بأنّ الغلّة للمشتري (ألا ترى أنها لو احترقت كانت من ماله) بل الظاهر منه معلومية الحكم بحيث لا يقبل الشبهة، ويصحّ التعليل به لحكم آخر.
ومثله قولهعليهالسلام في ذيل رواية معاوية بن ميسرة، ولأنّ الأصل عدم الانتقال الى البائع قهراً عليه، آناً ما قبل التلف.
والظاهر أنّ الخيار لا يرتفع بذلك، فللبائع ردّ الثمن واسترجاع قيمة المبيع، أو مثله إن كان مثليّاً.
ويمكن أن يقال: إنّ الشرط الردّ، واسترجاع المبيع يجب لتلف المبيع، لم يبق محلّ للخيار. وبعبارة اخرى: الشرط هو السلطنة على استرجاع المبيع بعد الردّ، وهذا المعنى يتوقّف على بقاء المبيع، فثبوت الخيار مشروط ببقاء العين، فتلف المبيع نابع
____________________
(١) و (٢) الخلاف: ج ٣ ص ٢٢ مسألة ٢٩.
عن ثبوت الخيار بالردّ.
ثمّ إنّ ذلك لا ينافي وجوب إبقاء المبيع على المشتري إلى انقضاء زمان الخيار، لأنّ شرط الاسترجاع في معنى شرط إبقاء المبيع على المشتري، وقبوله التزام بالابقاء، فهو من حقوقه فيجب عليه.
وعلى هذا، فلو أتلفه أو نقله نقلاً لازماً كان للبائع الفسخ، ولو قبل الردّ لتخلّف الشرط، أو لأنّ شرط الاسترجاع بعد الردّ على الاطلاق موجب لحدوث حقّ للبائع، مانعٍ عن تصرف المشتري في المبيع تصرفاً ينافي ذلك، كإتلافه أو نقله، بل يوجب عدم نفوذ الثاني بدون إجازته، نظير منع حقّ الرهن عن نفوذ تصرف الراهن بدون إجازة المرتهن.
وهذا الوجه أنسب لما ذكرنا من سقوط الخيار بالتلف، وإن كان الأوّل أيضاً صحيحاً من حيث كونه مسقطاً لخيار الشرط، إلاّ أنه لا يبقى معه ثمرة بين السقوط وعدمه.
ولو تلف الثمن، فهو إمّا بعد الردّ، أو قبله، فعلى الأوّل يكون من المشتري، بناءً على أنّ التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له، حتى بالنسبة الى الثمن، وحينئذ ينفسخ البيع بالتلف.
وربّما يمنع عن ذلك تمسّكاً برواية معاوية بن ميسرة، وفيها قال له أبو الجارود: فإنّ هذا الرجل قد أصاب في هذا المال في ثلاث سنين. قال: (هو ماله) وقالعليهالسلام : (أرأيت لو أنّ الدار احترقت من مال من كانت تكون، الدار دار المشتري).
قلت: لعلّ وجه الاستدلال أنّ مجرّد كون تلف الدار من مال المشتري ليس فيه دلالة على ما قصد إثباته، وهو كون الثمن للبائع قبل الردّ، لجواز أن يكون للمشتري، ويكون المبيع للبائع مع كون تلفه على المشتري فله استرداد الثمن من البائع، ودفع قيمة المبيع الى البائع، فيكون المقصود من ذلك إثبات كون المبيع للمشتري بذلك لا إثبات كون الثمن للبائع بإزاء المبيع قبل الردّ، وهذا لا يتمّ إلاّ بعد لزوم كون تلف
المبيع على المشتري، لكونه مالاً له قبل التلف، وعدم انفكاك أحدهما عن الآخر، وهذه الملازمة - إن سلمت - كان مقتضاه كون تلف الثمن على البائع.
وفيه: أنّ الاستدلال مبنيّ على الملازمة الغالبية، وإلاّ فالانفكاك معلوم في الجملة. فلعلّ هذا الثمن من أفراد غير الغالب، ولعلّ النكتة في العدول عن الاستدلال بكون تلف الثمن من مال البائع - مع هذه الملازمة الغالبية الى كون المبيع ملكاً للمشتري - تمسّكاً بهذه الملازمة: كون تلف الثمن على المشتري، وكونه من أفراد غير الغالب.
وبالجملة: الرواية لا تدلّ إلاّ على أنّ تلف المبيع على المشتري، ونماء الثمن للبائع، وهما لا ينافيان قاعدة كون تلف الثمن ممّن لا خيار له.
نعم، كون نماء الثمن للبائع مع كون تلفه من المشتري ينافيان قاعدة أنّ الخراج بالضمان، ومخالفة هذه القاعدة على تقدير ثبوت كون تلف الثمن من المشتري لا يختصّ بهذا المورد، فأنّ تلف المبيع اذا كان الخيار مخصوصاً بالمشتري يكون من البائع، ونماؤه يختصّ بالمشتري.
فهذه الرواية لا تختصّ بحكمٍ ينافي كون التلف ممّن لا خيار له، حتى يستكشف منه عدم ثبوت القاعدة في جانب الثمن.
وإن كان التلف قبل الردّ فالظاهر أنّ التلف من البائع لعدم الخيار.
ودعوى ثبوته بالقدرة على سببه، وقد عرفت الكلام فيها.
نعم، إن قلنا: إنّ قاعدة كون التلف ممّن لا خيار [ له ](١) موردها تزلزل البيع، وإن لم يكن الخيار فعليّاً، كان تلف الثمن على المشتري، فيفسخ البيع ، وعلى تقدير منع جريان القاعدة - هنا - في التلف قبل الردّ أو مطلقاً لا يسقط خيار المشتري بتلف الثمن، بل له ردّ البدل واسترجاع المبيع.
صرّح بذلك شيخنا في المكاسب(٢) . ولي فيه تأمل، لأنّ مفروض الكلام: إن
____________________
(١) اضفناها لضرورتها في المتن.
(٢) المكاسب: الخيارات ٢٣٢.
كان صورة ردّ عين الثمن فبقاء الخيار منافٍ للشرط، وإن كان أعمّ من ذلك، ومن شرط ردّ الثمن، وردّ البدل على تقدير التلف والإتلاف أو خصوص التلف فإطلاق الحكم ببقاء الخيار غير متوجّه. مع أنّ إجراء قاعدة كون التلف ممّن لا خيار له في صورة اشتراط الخيار، حتى مع رد البدل مطلقاً، أو في الجملة يحتاج الى تأملٍ في تلك المسألة، وليس هنا محلّه.
الخامسة: لا إشكال في أنّه إذا كان الردّ المعلّق عليه الخيار، الرد الى شخصه لا يتحقّق الخيار بالردّ الى غيره، ممّن يقوم مقامه بحكم الشارع أو بجعله، كما أنه لا إشكال في التحقق به اذا كان هو الردّ، ولو الى من يقوم مقامه على حسب ما شرط.
ولو شرط الردّ الى المشتري، ولم ينصّ على التخصيص والتعميم ففي قيام الردّ الى من يقوم مقامه مقام الردّ اليه في السببيّة، لحصول الخيار كما حكي ذلك عن المحقّق القمي(١) -رحمهالله - واختاره شيخنا -قدسسره - في المكاسب(٢) ، أو العدم كما حكي عن السيّد -رحمهالله - في المناهل(٣) . وجهان:
الأوّل: أنّ الظاهر، أنّ المراد من الردّ: حصول الثمنعند المشتري، وتملّكه له حتى لا يبقى بعد الفسخ في ذمّة البائع، وهو كما يحصل بالردّ الى شخصه، كذلك يحصل بالردّ الى من يقوم مقامه ولو بحكم الشارع.
والثاني: أنّ الردّ الى الحاكم من غير أن يكون قبضه من المشتري، لا يكون ردّاً الى المشتري، لأنّ المفروض أنّ المال قبل الفسخ ملك للبائع، ويد الحاكم على ما يكون مالاً للمشتري بمنزلة يد المشتري دون غيره، وقبضه المال عن المشتري، الذي به يتحقّق الردّ الى المشتري إنّما يكون بمنزلة قبض المشتري اذا كان صلاحه قبض الحاكم ليفسخ المشتري.
____________________
(١) جامع الشتات: ج ١ ص ١٩٥ س ١٠.
(٢) المكاسب: الخيارات ص ٢٣٢.
(٣) المناهل: كتاب البيع ص ٣٣٤ س ١٠.
والحاصل: أنّ مجرّد وضع الحاكم يده على الثمن ليس بمنزلة كون المال عند المشتري، لأنّ ولاية الحاكم أنّما هو على ما تحقق دخوله في ملك المشتري، ووضعه اليد عليه عن المشتري إنّما يتحقّق به الشرط اذا كان ذلك مصلحةً له، بمعنى توقّف حفظه ماله على ذلك، وإلاّ فليس للحاكم التصرف في ملك الغائب اذا كان مصلحة عليه الحفظ. وقد لا يكون ذلك مصلحة له بهذا المعنى.
ويمكن الجواب عن الأخير، بأنّ الشرط ليس قبض المشتري للثمن حتى يقال: إن قبض الحاكم عن المشتري ما لم يكن مصلحة له ليس قبض المشتري، وليس حصول المال تحت يد المشتري حتى يقال: إن يد الحاكم على مال المشتري بمنزلة يد المشتري، لا يده على مال الغير، بل الشرط أن يجعل البائع المشتري ومن يقوم مقامه متمكّناً من التصرف في المال.
وهذا المعنى لا يعتبر فيه أمر يناط باختيار الحاكم، حتى يناط حصوله بالمصلحة، ولا يعتبر فيه أيضاً فعليّة سلطنة المشتري، وحصول المال عنده حتى يقال: إن الحصول عند الحاكم ما لم يكن الثمن ملكاً للمشتري لا يكون بمنزلة حصوله عند المشتري وقبضه عنه، إنّما يجعل الحصول عنده بمنزلة الحصول عند المشتري اذا كان ذلك عن مصلحة.
ويجري هذا الاختلاف في الردّ الى عدول المؤمنين، مع عدم التمكّن من تمكين الحاكم. ولو اشترى وليّ الطفل عنه - كالأب - بشرط الخيار للبائع بعد الردّ فهل يكون الردّ الى وليّه الآخر - كالجدّ مطلقاً - موجباً لحصول الخيار، أو إذا لم يتمكّن من الردّ الى الوليّ البائع، أو لا يكون ذلك موجباً له مطلقاً ؟ وجوه، ويظهر وجه الأوّل، والأخير من التأمّل فيما سبق.
وأما الثاني: فلعلّ وجه ظهور اعتبار الرّد الى متولي الشراء، مع التمكّن منه في حصول الشرط، وهو غير بعيد، وتجري هذه الوجوه فيما اذا اشترى حاكم عن الطفل فردّ البائع الى حاكم آخر.
لا يقال: إنّ الوجه الأوّل لا يجري هنا - ولو قلنا به في الفروع السابقة - لأنّ ولاية
الحاكم الثاني على مال الطفل، الذي تحت يد الحاكم الأوّل مشروط لعدم كون تصرّفه مزاحمةً للحاكم الأوّل.
لأنّا نقول: مجرّد تمكينه الغير الاختياري، والتصرف الحاصل بفعل البائع لا يكون مزاحمةً، ولا يتوقّف ذلك التمكين على السلطنة الفعلية على التصرّف فيما يردّ اليه، حتى لو أنّ سلطنة الحاكم على هذا المال ما دامت مزاحمةً للحاكم الأوّل ليست سلطنةً عن الطفل، وإلاّ يمكن الردّ الى غير المشتري، لأنّ الحاكم ليس له سلطنة على غير مال الغائب، وسلطنته على القبض عن المشتري - أيضاً - مشروط بكونها مصلحةً له بغير المشتري ليس له سلطنة على هذا المال، بل لو فرض توقف الردّ على السلطنة الفعلية على التصرف في عين المدفوع لما كان الردّ الى المشتري - أيضاً - ممكناً، لأنّه قبل الردّ ليس له سلطنة فعلية على التصرف في ذلك المدفوع اليه.
نعم، يجب على الحاكم الثاني ردّ الثمن المقبوض الى الأوّل، بعد تحقق الفسخ، لأنّ إمساكه وحفظه - حينئذٍ - مزاحمة. مع إمكان أن يقال: إنّ المزاحمة في المال الذي كان تحت يد الحاكم الأول لا تجوز، وهذا مال جديد للطفل، فلا تكون مزاحمته حراماً. وفيه تأمل؛ فأن صدق المزاحمة في نظر العرف كافٍ في الحرمة، ومع الشك فيه، الأصل عدم الولاية. إلاّ أن يقال: إنّ المقتضي - وهو أهليّة الولاية - موجود، والأصل عدم المانع، وفيه تأمّل.
السادسة: الظاهر من إطلاق ردّ الثمن ردّ تمامه، لأنه الثمن، والبعض بعضه، فلو ردّ البعض وأراد الفسخ لم يكن له ذلك.
نعم له الرد تدريجاً الى أن يكمل فيفسخ حينئذ. فعلى هذا: لو ردّ البعض كان ذلك باقياً في ملكه، ولا يجوز للمشتري التصرف فيه.
وهل يكون أمانةً، فلا يضمن إلاّ بالإتلاف، وما يقوم مقامه من التلف عند التفريط أو يكون مضموناً مطلقاً؟ الظاهر ذلك، لأنّه نظير المقبوض بالسوم، فأنّ المشتري أنّما أقدم على أخذه على أن يؤدّه، أو بدله على تقديري إمضاء العقد والفسخ الى البائع، والبائع لم يجعله نائباً عنه في حفظه، وإنما أدّاه اليه على وجه الثمنيّة،
فعموم (على اليد)(١) سليم عمّا يوجب الخروج عنه.
نعم، لو خرج بالاستئمان فلا إشكال في عدم الضمان بدون التفريط.
وهل يصحّ شرط السلطنة على الفسخ فيما يردّ بدله من أجزاء المبيع، فبعد ردّ كل جزء يفسخ ما يقابله؟ الظاهر، نعم، بناءً على قبول العقد للتبعيض في الانفساخ اختياراً، ولي فيه تأمّل. وحينئذ. فلو ردّ البعض وفسخ ما يقابله، فإن اقتصر على فسخه الى أن انقضى مدّة الخيار كان المشتري مسلّطاً على الردّ في الباقي، لتبعّض المبيع عليه، وشرطه سلطنة البائع على الفسخ في البعض ليس التزاماً بالعقد، بالنسبة الى ما لم يفسخه البائع، ومنه تبيّن أنّ له الخيار قبل مضيّ زمان الخيار أيضاً. ولو شرط السلطنة على الفسخ في التمام بردّ البعض جاز.
قال شيخنا -قدسسره - في المكاسب: ويجوز اشتراط الفسخ في الكلّ، بردّ جزءٍ معيّنٍ من الثمن في المدة، بل بجزءٍ غير معيّنٍ، فيبقى الباقي في ذمّة البائع بعد الفسخ(٢) ، انتهى.
أقول: لعلّ مراده -رحمهالله - من الجزء غير المعيّن الفرد المنتشر بين الأفراد، المقدّرة بمقدارٍ معينٍ مع التساوي في الجنس والقيمة، مثل درهم من الدراهم، أو الربع من الكلّ بعد فرض اتحاد الأجزاء جنساً، وإلاّ فشرط رّد الجزء المجهول، قدراً وجنساً أو من إحدى الجهتين يؤدّي الى الغرر المفسد للعقد.
وقوله: « يبقى الباقي في ذمّة البائع » محمول على عدم بقاء عين الباقي، ضرورة أنّ العين بعد الفسخ تخرج عن ملك المشتري، ويجب على البائع ردّها اليه، ولا تتعلّق به الذمّة ما لم يكن تالفاً.
السابعة: كما يجوز للبائع شرط الفسخ بردّ الثمن كذلك يجوز للمشتري شرط الفسخ بردّ المبيع. ويجري فيه جميع المسائل السابقة من غير فرق، ويجوز اشتراط
____________________
(١) عوالي اللئالي: ج ٢ ص ٣٤٥ ح ١٠.
(٢) المكاسب: الخيارات ص ٢٣٢ س ٢٩.
الفسخ لكلّ منهما بردّ ما انتقل اليه.
الثامنة: ينتقل هذا الخيار الى الوارث في بعض الصور بالشرط لا بالإرث.
وتوضيحه: أنّ المراد من الردّ والخيار بعده قد يكون ردّ خصوص البائع، وخياره كذلك، وحيئنذٍ لا يكون للوارث الخيار بعد ردّه، لأنّ الشرط لم يحصل، والمشروط - أيضاً - غير قابل للانتقال، وذلك نظير شرط الخيار للأجنبيّ، في أنّه لا ينتقل الى وارثه لاعتبار الخصوصيّة.
وقد يكون ردّ البائع على وجهٍ يشمل غيره ممّن يقوم مقامه، وخياره على وجه الخصوصية، وحينئذٍ لا ينتقل الى الورثة ولو كان موت البائع بعد فعليّة خياره، لردّه الثمن الى المشتري بنفسه أو وكيله، لأنّ الخيار غير قابل للانتقال، وقد يكون عكس هذه الصورة، وهو ردّ خصوص البائع مع عدم اعتبار الخصوصيّة. وذلك يتصوّر على وجهين:
أحدهما: أن يكون المراد: خيار البائع عند وجوده، ومن يقوم مقامه عند عدمه، وحينئذ ينتقل الى الورثة لعموم الشرط.
الثاني: أن تكون خصوصيّة البائع غير ملحوظ أي لم يعتبر عدم ثبوت هذا الخيار لغيره، ولا اعتبر ثبوته له، نظير شرط الخيار في مدّة من غير شرط الردّ، وحينئذٍ، فإن حصل الردّ من البائع يكون الخيار منتقلاً الى الورثة بعده بالإرث، لأنّه لم يكن العموم مراداً في الشرط حتى يكون ثبوته به، ولا كان خصوص البائع وشخصه ملحوظاً حتى لا يكون الخيار قابلاً للانتقال.
وقد يكون المراد من الردّ والخيار: ردّ البائع وخياره من غير نظر الى الخصوصيّة وشخص البائع. وحينئذ، فإن أريد مع ذلك العموم منهما كان الانتقال الى الورثة قبل تحقّق الردّ بالشرط، وكذلك بعده.
وإن لم يرد العموم منهما، فإن تحقّق الردّ من البائع انتقل الى الوارث بالإرث، وإن لم يتحقّق فانتقاله الى الوارث تابع لكون الخيار المعلّق على حصول الردّ من حقوق البائع، بحيث تكون القضية التعليقية - وهي السلطنة على الخيار - إن تحقق
ردّها من حقوقه، فإن كان من الحقوق انتقل إليهم، وإلاّ فلا معنى للانتقال، وإن أريد العموم من الردّ، ولم يلاحظ في الخيار أو العكس الأمر.
ففي الصورة الاولى ينتقل بعد الردّ بالإرث، وقبله يتوقّف على كون القضية التعليقية من الحقوق المنتقلة بالإرث.
وفي الصورة الثانية ينتقل بعد الرّد: البائع في حياته الى الورثة بعد ثبوته بالشرط، وقبل الردّ يتوقّف على أن يكون الردّ الذي [ بيّنّاه ].
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه رب العالمين والصلاة على محمد وآله. ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين.
مسألة: لا إشكال في أنه لا يختصّ خيار الشرط بالبيع، وأنّه يجري في غيره في الجملة. ونفى الخلاف عن دخوله في عقود المعاوضات شيخنا في المكاسب(١) . وأمّا دخوله في غيرها ففيه إشكال واختلاف. ولنقدّم على المطلوب مقدّمةً:
فنقول: مقتضى عموم قولهعليهالسلام : (المؤمنون عند شروطهم)(٢) صحّة هذا الشرط مطلقاً، عدا مواضع خاصّةٍ وقع الإتّفاق على عدم صحّة الشرط المذكور فيها. وقد يدّعى ابتناء ذلك على جريان التقابل في المشروط فيه، وعدمه.
فعلى الأوّل يؤخذ بالعموم. وعلى الثاني يحكم بفساد الشرط؛ نظراً الى أنّ أدلّة الشرط لا تجعل غير السبب الشرعيّ سبباً.
أقول: ويرد عليه: أنّ معنى الوفاء بالشرط العمل بمقتضاه، ولا ريب أنّ مقتضى شرط الخيار ترتيب آثار فسخ المعاملة على فسخ ذي الخيار، ووجوب هذا المعنى لازم مساوٍ لصحّة الفسخ، فكلّ شرطٍ لم يقم دليل، من إجماعٍ أو غيره على خروجه عن العموم كان مقتضاه العمل به.
____________________
(١) المكاسب: الخيارات ص ٢٣٢.
(٢) عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٢١٧ ح ٧٧.
فإن قلت: اذا لم يعلم جريان التقابل، في العقد المشروط فيه كانت قابلية الانفساخ مشكوكةً، فلا يعلم أنّ الشرط المذكور غير مخالفٍ للكتاب والسنّة، فلا يمكن التمسّك بالعموم، لأنّ الفرد المشكوك دخوله في العامّ أو المخصّص لا يؤخذ فيه بالعموم، بل الواجب الرجوع إلى دليلٍ ثالثٍ في حكمه، ولو كان أصلاً، ولا ريب أنّ الأصل الفساد، لأنّ الأصل عدم وقوع المعاملة المقيّدة بهذا القيد، والأصل عدم تأثير في رفعها - إن قلنا: إنّ الشرط الفاسد لا يؤثّر في فساد العقد - إلاّ أن يقال:
إنّ الصحّة إن تحقّقت على تقدير فساد الشرط فهي مع الخيار، فالخيار ثابت على تقدير فساد الشرط وصحته - إن قلنا بصحة العقد - ولكن في ثبوت الخيار على تقدير الفساد تأمّل. يأتي الكلام فيه في باب الشروط.
قلنا: سيأتي في باب الشروط - إن شاء اللّه تعالى - أنّ المرجع فيما يشكّ مخالفته للسنّة هو العموم، عملاً بأصالة عدم المخالفة. والمناقشة فيها بأنّ الشكّ في المخالفة الدائمية، لا في المخالفة في الجملة، مع اليقين بعدمها في زمانٍ سابقٍ.
توضيحه: أنّ الكتاب - مثلاً - إن كان مخالفاً لشرطٍ خاص. بجميع قيوده فهو مخالف له دائماً، وإن لم يكن مخالفاً فليس كذلك دائماً، فالشك في المخالفة شك في المخالفة الدائمية.
وهكذا الكلام بالنسبة الى مخالفة السنّة. مدفوعة بأنّ مرجع الشك في المخالفة الى الشكّ في جعل الحكم على وجهٍ لا يقبل التخلّف، ولو بالشرط، والأصل عدم الجعل بهذا الوجه.
فإن قلت: أصالة عدم أحد العنوانين لا يثبت العنوان الآخر، ولذا لا يحكم بأصالة عدم الفسق: أنّ مشكوك العدالة عادل.
قلنا: إنّ المستثنى منه في الحديث له عنوان خاصّ، يتوقف إدراج الأفراد المشكوكة فيه على إحراز ذلك العنوان، بل الخارج له عنوان خاصّ، فأصالة عدمه يوجب الدخول فيه.
والحاصل: أنّ الحديث بعد ملاحظة المخصّص يكون مفهومه: كلّ شرط يجب الوفاء به إلاّ المخالف، فكلّما لم يكن مخالفاً، ولو بالأصل داخل في عمومه هذا.
ولكنّ الإنصاف: أنّ دلالة أدلّة الشروط على صحة مثل هذا لشرط لا يخلو من غموض، لأنّ تأثير الفسخ في رفع المعاوضة وغيرها يتوقّف على كونه سبباً شرعيّاً في ذلك في نفسه، وعلى حصول شرطه الذي هو: إمّا رضا من يفسخ عليه، أو ما يقوم مقام الرضا، وشرطه الخيار إن كان المراد منه شرط السببيّة الشرعيّة للفسخ، فهو راجع الى شرط الحكم.
وإن كان المراد منه: حصول حقّ لذي الخيار، يوجب سلطنةً على الفسخ - بحيث يكون التزام المشروط عليه به بمنزلة الرضا الفعلي - فالوفاء به لا يقتضي، إلاّ أنّ المشروط عليه لا يكون مسلّطاً على المنع، ويكون الفسخ على تقدير وقوعه خاصّاً لشرائط الصحة، قابلاً للتأثير في رفع العقد، واقعاً قهراً على المشروط عليه. ويجب الوفاء به عليه على هذا التقدير.
والحاصل: أنّ حقيقة الشرط على هذا التقدير رفع سلطنة المشروط عليه على المنع من الفسخ، وعدم كون رضاه الفعلي شرطاً في تأثير الفسخ.
ولا ريب أنّ نفي شرطيّة الرضا، وقطع سلطنة المشروط عليه على المنع من الفسخ أعمّ من كونه سبباً في رفع العقد ومؤثّراً في ذلك.
لا يقال: حقيقة شرط الخيار هي سلطنة المشروط له على فسخ المعاملة. وقد عرفت أنّ وجوب الوفاء به لازماً مساوٍ لحصول ذلك، فهو يقتضي حصول العلّة التامّة لتأثير الفسخ إذا كانت السلطنة عليه شرطاً في ضمن العقد، فالعموم يقتضي السببيّة الشرعية، وكونه مؤثّراً قهراً على المشروط عليه.
لأنّا نقول: ليس كلّ شرطٍ يجب الوفاء به، بل مورد أدلّة الشروط ما يكون وضعه ورفعه باختيار طرفي الشرط، مع قطع النظر عن الشرط، ويكون الشرط موجباً لتعيّن أحد الأمرين، وسببيّة الفسخ ليست من الامور التي تكون تحت اختيارهما.
فشرط الخيار إن كان المراد منه شرط كون ذي الخيار مسلّطاً على الفسخ - بمعنى
كون فسخه سبباً ومؤثّراً في ذاته وواقعاً قهراً على المشروط عليه - لا يكون داخلاً في عموم أدلة الشروط، وإن كان المراد منه مجرّد عدم توقّف تأثيره على حصول الرضا الفعلي من المشروط عليه.
فصحّة هذا الشرط معناها: قطع سلطنة المشروط عليه. ووجوب الوفاء بمثل هذا الشرط ليس معناه ترتيب آثار فسخ المعاملة على فسخ ذي الخيار مطلقاً، بل معناه: يجب ترتيب آثار الفسخ عليه على تقدير كونه في نفسه سبباً، ولذاته رافعاً للعقد.
ومن التأمّل فيما ذكرنا يظهر: أنّ منع دلالة أدلّة الشروط - هنا - لا دخل له، باستثناء الشرط المخالف للكتاب، حتى لو فرضنا أنّ الشرط المخالف - أيضاً - داخل تحت العموم كان منع الدلالة هنا متّجهاً، فتأمل.
فتلخّص مما ذكرنا: أنّ كلّ عقدٍ أو إيقاعٍ كان التقابل فيه جارياً يكون مقتضى العموم صحّة شرط الخيار فيه، وكلّ ما لم يكن التقابل فيه جارياً، أو شكّ في جريانه فيه لم يكن مقتضى العموم صحّته، فالمرجع فيه أصالة الفساد. ولكنّ التمسّك بأصالة الفساد - على تقدير البناء على أنّ فساد الشرط لا يوجب فساد العقد - لا يخلو من إشكال، لأنّ المراد منها: إن كان أصالة فساد العقد المقيّد بالشرط بمعنى أصالة عدم وقوعه على وجهٍ أوقعه المتعاقدان مقيّداً فهي لا تنافي حصول الخيار من وجهٍ آخر بعد البناء على وقوع العقد صحيحاً مع فساد قيده و إن كان المراد أصالة فساد الفسخ الصادر من المشروط له، فسيأتي أن مقتضى القاعدة على تقدير صحة العقد ثبوت الخيار لمن حكم بفساد شرطه، فالمشروط له الخيار، سواء حكمنا بفساد شرطه أو صحته، إلا أن يقال بمنع ثبوت الخيار على تقدير فساد الشرط، وللكلام في ذلك محلّ آخر - سيأتي إن شاء اللّه تعالى - اذا عرفت ذلك فيقع الكلام تارةً في العقود الجائزة، واخرى في اللازمة، وثالثةً في الإيقاعات.
فنقول: أمّا الأوّل: فقد يقال بفساد الشرط، نظراً الى أنّ الخيار فيها ثابت دائماً.
قلت: توضيحه أنّ معنى صحّة الشرط كونه موجباً لحصول أمرٍ لو لم يكن الشرط
لم يكن حاصلاً. وهذا المعنى لا يمكن تحقّقه في العقود الجائزة، لحصول الخيار فيها على تقدير عدم الشرط - أيضاً - دائماً.
لا يقال: الخيار ملك الفسخ، وبعبارة اخرى: حقّ لذي الخيار في العقد يوجب سلطنته على رفع أثر العقد، وليس شيء من العقود الجائزة مورداً للخيار بهذا المعنى، بل الخيار فيها: إمّا من آثار بقاء السلطنة على الملك كما في الوديعة والعارية، والوكالة على التصرف في الاموال، والمضاربة. وإمّا حكم صرفٍ، وهو جواز ارتجاع العين كما في الهيئة الجائزة. وإمّا من آثار بقاء السلطنة على النفس كما في الوكالة على النكاح، إلى غير ذلك من الامور الموجبة للجواز.
والحاصل: أنّ الخيار بمعنى ملك فسخ العقد الناشيء من السلطنة على نفس العقد، وكون أمره باختيار المشروط له ليس حاصلاً في العقود الجائزة.
لأنّا نقول: المراد من شرط الخيار: السلطنة على رفع العقد، وكون منشأه حقّاً في العقد ليس داخلاً في مفهوم الشرط الذي يقيّد به العقد، ولو كان داخلاً في مفهومه فهو مصطلح الفقهاء. وأما عرفاً، فليس إلاّ السلطنة على رفع العقد، وهي حاصلة بدون الشرط.
ولكن يمكن المناقشة في ذلك، بأنّا لا نسلم أنّ معنى الصحة هو التأثير في حصول ما لو لم يكن الشرط لم يكن حاصلاً، بل هي عبارة عن التأثير، غاية الأمر أنّه إن وجد سبب آخر للتأثير كان ذلك الأثر مستنداً الى السببين كما هو الشأن في المؤثّرين المتواردين على أثرٍ واحدٍ، فالخيار - على تقدير عدم الشرط - مستند الى سبب الجواز من الامور المذكورة سابقاً وعلى تقدير الشرط مستند إليهما.
ودعوى الخلوّ عن الفائدة خالية عن الفائدة، لأنّ ذلك لا يمنع الصحة.
لا يقال: مرجع الخيار حقيقةً الى حقّ في العين يوجب السلطنة على ارتجاعه بفسخ العقد، وهذا المعنى لا يعقل حصوله في مثل العارية والوديعة، لأنّ السلطنة على المال حاصلة بجميع أنحائها.
لأنّا نقول: لا نسلّم أن الخيار مرجعه الى ذلك، بل الخيار حقّ في العقد، ولذا
يتحقّق في العقود التي ليس جهة الماليّة فيها من مقوماتها كما في النكاح، بل لا يتصوّر هذا المعنى في مثل خيار الزوجة، ثم إنّه يتصوّر الفائدة لشرط الخيار بالنسبة الى العقود الجائزة، التي تلزم ببعض الملزمات كالتصرف في الهبة على القول وتلف العين فيها. ولكنّ ذلك خارج عن الفرض، لأنّها بهذا الاعتبار تدخل في العقود اللازمة.
ويمكن أن يستدلّ على الفساد فيها، بأنّ الشرط في العقد الجائز لا يجب الوفاء به، وذلك بالنسبة الى مثل الرهن، الذي يكون لازماً من طرف الراهن لا يتمّ، إذ لو شرط المرتهن لنفسه الخيار كان الوفاء به على الراهن واجباً.
ثمّ إن قلنا: بفساد الشرط فهل يكون موجباً لفساد العقد هنا، كما يكون موجباً له في العقود اللازمة - على القول به - أم لا ملازمة ؟
أقول: إن كان منشأ الفساد كون الرضا بالمقيد، وأنّ عدم القيد موجب لعدم المقيّد فالظاهر الصحة، لأنّ القيد - هنا - حاصل بدون الشرط، ومعنى فساده أنّه لا يكون له دخل في حصول الخيار، وأنّ وجوده كعدمه، وإن كان منشأ الأخبار الخاصّة كما قد يستدلّ بها على ذلك في بابه، والظاهر اطّراد الحكم لما نحن فيه إلاّ أن يمنع دلالة الأخبار، ويدّعى اختصاصها بصورة عدم حصول مطلوب المشروط له أصلاً.
نعم، لو كان الشرط هو الخيار بالمعنى المصطلح عليه، لا مجرد السلطنة على رفع العقد كان القول بفساد الشرط مستلزماً للقول بفساد العقد؛ بناء على أنّ فساده موجب لفساده.
وممّا ذكرنا، علم أنّ التكلم في صحّة شرط الخيار في العقود الجائزة - لا يثبت - يترتّب عليه كثير فائدة، فالاضراب عن إشباع الكلام فيه الى الكلام في العقود اللازمة أولى. فنقول:
منها: ما وقع الاتفاق على عدم دخول شرط الخيار فيه كالنكاح، فقد حكي
عن الخلاف(١) والمبسوط(٢) والسرائر(٣) وجامع المقاصد(٤) والمسالك(٥) الاجماع على ذلك.
ومنها: ما وقع الاختلاف في دخوله فيه، وهي كثيرة:
منها: الوقف، فأنّ المشهور فيه أنّه لا يدخله. وفي المسالك(٦) أنّه موضع وفاق، وربّما يستظهر من المحكي عن السرائر(٧) والدروس(٨) وجود الخلاف فيه.
وكيف كان، فيمكن أن يستدلّ على عدم الدخول بالموثق - كما قيل -: من أوقف أرضاً، ثم قال: إن احتجت إليها فأنّا أحقّ بها، ثم مات الرجل، فأنّها ترجع ميراثاً(٩) . فأنّ الرجوع ميزان كاشف عن الفساد، وليس ذلك إلاّ لفساد الشرط.
قلت: لا نسلّم أنّ شرط الأحقّيّة معناه شرط الخيار، بل هو إمّا شرط العود عند الحاجة كما هو الظاهر أو شرط كونه من الموقوف عليهم عند الحاجة، وفساد الشرط بأحد المعنيين لا يوجب فساد شرط الخيار.
ودعوى أنّ المستفاد منه، أنّ إبقاء الوقف لنفسه علقة في الوقف، ولو كانت هي الخيار موجب للبطلان جزاف من القول.
وقد يستدلّ - أيضاً - بأنّه فكّ ملكٍ بلا عوضٍ، وبأنّه يعتبر فيه القربة. والكبرى في اولى الصغريين ممنوعة، وأمّا في الثانية فيمكن أن يستدلّ لها بما دلّ على أنّه لا رجوع فيما كان للّه.
____________________
(١) الخلاف: ج ٣ ص ١٦ مسألة ١٧.
(٢) المبسوط: ج ٢ ص ٨١.
(٣) السرائر: ج ٢ ص ٢٤٦.
(٤) جامع المقاصد: ج ٤ ص ٣٠٣.
(٥) مسالك الافهام: ج ١ ص ١٨١ س ٤.
(٦) مسالك الافهام: ج ١ ص ١٨١. (٧) السرائر: ج ٢ ص ٢٤٥.
(٨) الدروس الشرعيّة: ص ٣٦٠.
(٩) راجع وسائل الشيعة: ب ٣ من ابواب احكام الوقوف والصدقات. ج ١٣ ص ٢٩٦.
كقولهعليهالسلام : (لا ينبغي لمن أعطى للّه أن يرجع فيه)(١) .
وقولهعليهالسلام : (إنّما الصدقة للّه، فما جعل للّه فلا رجعة له)(٢) .
وفي النبويّ: (مثل الراجع في صدقته مثل الراجع في قيئه)(٣) . وفي دلالتها على المدّعى نظر؛ لمنع شمولها للوقف أوّلاً، ومنع دلالتها على المنع، حتى في صورة الاشتراط ثانياً؛ لإمكان أن يقال: إنّها في بيان حكم الصدقة من حيث هي.
ويؤيّده قولهعليهالسلام - في بعض هذه الأخبار - : (وما لم يعط للّه أو في اللّه فأنّه يرجع فيه)(٤) .
ويؤيده أيضاً قول السائل في بعضها: الرجل يتصدّق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته(٥) ؟ فأنّ الظاهر منه أنّه سؤال عن حكمها من حيث هي. إلاّ أن يقال: إنّ ترك الاستفصال في مقام الجواب يدلّ على العموم.
وأمّا صحيحة محمد بن مسلم: ولا يرجع في الصدقة اذا ابتغى وجه اللّه عزّ وجلّ(٦) . واختصاصه بغير الوقف بقرينة قولهعليهالسلام : (اذا ابتغى. الى آخره) ظاهر. نعم، في النبوي نوع دلالةٍ على المنع إن سلّم شموله لما نحن فيه.
فالعمدة هو الاتفاق المحكيّ في المسالك(٧) المؤيّد بالشهرة، وبما مرّ من القاعدة.
ومنها: الهبة المقصود لها القربة، فأن ظاهر المحكيّ عن التذكرة(٨) دخول خيار الشرط فيه، وفي المحكيّ عن موضع آخر(٩) منها إلحاق مطلق الصدقة بالوقف.
____________________
(١ و ٤) وسائل الشيعة: ب ٣ من ابواب الهبات ح ١ ج ١٣ ص ٣٣٤.
(٢) وسائل الشيعة: ب ١١ من ابواب احكام الوقوف و.. ح ١ ج ١٣ ص ٣١٦.
(٣) وسائل الشيعة: ب ١١ من ابواب احكام الوقوف و.. ح ٢ ج ١٣ ص ٣١٦.
(٥) وسائل الشيعة: ب ١٠ من ابواب الهبات ح ١ ج ١٣ ص ٣٤٢.
(٦) وسائل الشيعة: ب ١١ من ابواب الوقوف و.. ح ٧ ج ١٣ ص ٣١٧.
(٧) مسالك الافهام: ج ١ ص ١٨١ س ٥.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٢٢ س ٢٩.
(٩) تذكرة الفقهاء: كتاب الوقف ج ٢ ص ٤٣٤ س ٤٠ المطلب الثالث في الالزام.
ويمكن أن يستدلّ للمنع بما مرّ من الأخبار، الدالّة على أنّه لا رجوع فيما كان للّه - وقد عرفت الكلام في دلالتها - إلاّ أنّ الشكّ في سببيّة الفسخ لرفعها - بناءً على ما مرّ - كافٍ في الحكم بالفساد.
ومنها: الصلح، فعن المبسوط(١) والخلاف(٢) عدم الدخول فيه مطلقاً. وعن التذكرة(٣) دخوله فيه، بل عن المهذّب البارع(٤) : دعوى الإجماع على الدخول فيه. وفصّل في التحرير(٥) بين ما كان في معنى الإبراء فلا يدخله، وبين ما كان معاوضةً فيدخله.
ومثله حكي عن جامع المقاصد(٦) وغيره، وهو الأقوى. أمّا أنّه لا يدخل فيه اذا كان في معنى الابراء فلما سيأتي - إن شاء اللّه تعالى - في الإيقاعات، مضافاً الى ما مرّ من الأصل. وأمّا أنّه يدخله اذا كان معاوضةً فللعموم، وعدم ما يصلح للتخصيص.
ومنها: الرهن. والكلام فيه من حيث الراهن، وإلاّ فهو من حيث المرتهن داخل في العقود الجائزة. وقد حكي عن بعض(٧) المنع عن ذلك، مستدلاً بأنّ الرهن وثيقة للدين. والخيار ينافي الاستيثاق.
واجيب بأنّ غاية الأمر كون وضعه على اللزوم، وهو لا ينافي جواز جعل الخيار بتراضي الطرفين.
أقول: إن كان الخيار منافياً للاستيثاق فلا يقبل التقييد بغير صورة الاشتراط،
____________________
(١) المبسوط: ج ٢ ص ٨٠.
(٢) الخلاف: ج ٣ ص ١٢ مسألة ١٠.
(٣) تذكرة الفقهاء: كتاب البيع ج ١ ص ٥٢٢ س ١٩.
(٤) المذهب البارع: ج ٢ كتاب الصلح ص ٥٣٨.
(٥) تحرير الاحكام: ج ١ - ٢ كتاب البيع ص ١٦٧ الفصل الثاني س ٣٠.
(٦) جامع المقاصد: ج ٤ ص ٣٠٤.
(٧) المكاسب: الخيارات ص ٢٣٤.
فالأولى أن يقال: إن اريد من المنافاة منافاته لحكمه الشرعي - لأنّ من أحكامه اللزوم - فهو مطلق ممنوع.
وإن اريد منافاته لمدلوله - نظير منافاة شرط عدم حصول الملك في البيع - فهو ممنوع. ولكنّ الأخير لا يخلو من نظر؛ فأنّ السلطنة على الارتجاع بدون أداء الدين يمكن أن يقال: إنّه منافٍ لكون المال وثيقة عرفاً.
وكيف كان، فإن علم عدم المنافاة فالظاهر - حينئذ - هو الصحة لسلامة العموم عن المعارض. إلاّ أن يقال: إنّ سببيّة فسخ الراهن مجهولة، وعلى تقدير رضا المرتهن بالفسخ فالمؤثر ردّه، لا فسخ الراهن. وقد مرّ أنّ عند الشكّ في السببيّة لا يمكن التمسّك.
وهكذا الأمر على تقدير الشكّ في المنافاة لعدم العلم بالمانع الموجب لتخصيص العموم، إلاّ أن يقال: إنّ الشكّ في المنافاة موجب للشكّ في قصد الإنشاء، فأصل العقد مشكوك الحصول.
وفيه: أنّ ظهور اللفظ في الانشاء حجّة شرعيّة ما لم يدلّ على خلافه دليل، وإن علم المنافاة ففساد الشرط ظاهر، لأنّه إمّا بكون العقد فاسداً رأساً أو هو خاصّة، فهو فاسد على أيّ حال. واحتمال فساد العقد دون الشرط فاسد للقطع بأنّ فساد العقد يوجب فساد الشرط. ولو فرض إمكان صحة الشرط بدون العقد فهنا يستحيل ذلك، لانتفاء متعلّق الشرط على تقدير فساد العقد، كما هو واضح.
وأمّا العقد، فهل الحكم بصحته وفساده مبنيّ على إفساد الشرط الفاسد، وعدمه، أو يختصّ هنا بالبطلان ؟ وإن قلنا بأنّ الشرط لا يكون مفسداً وجهان:
من أنّ المعلوم فساده هو خصوص الشرط، وليس للعقد جهة توجب فساده غير فساد الشرط.
ومن أن القصد الى إنشاء مفهوم العقد المقيّد بالشرط معلوم أنّه غير متحقّق، لأنّ قصد اتحاد المتنافيين لا يأتي من العالم بالمنافاة، وإيجاد المطلق - أيضاً - لا يعلم قصده، بل ظاهر اللفظ يقتضي عدمه، والكلام في مسألة إيجاب فساد الشرط فساد العقد
إنّما هو بعد إحراز تحقّق الإنشاء، ووقوع المعاهدة من المتعاقدين.
واعلم، أنّ محلّ الكلام إنّما هو ما اذا علم أنّ العاقد لم يقصد التجوّز، ولم يجعل أحد المتنافيين قرينةً على عدم إرادة ظاهر الآخر. وأمّا على هذا التقدير فلا إشكال في أنّ المتّبع قصده.
ومنها: الضمان، فعن ضمان التذكرة(١) ، والقواعد(٢) منع ثبوت الخيار، ولعلّ المنع: إمّا لكون الخيار منافياً لمفهوم التعهد عرفاً، أو لكون الضمان في معنى الإبراء.
قلت: أمّا المنافاة فالظاهر عدمها، لأنّ مفهوم الضمان ليس إلاّ نقل ما في الذمّة الى ذمّةٍ أخرى، وهو لا ينافي التقيّد بالخيار.
وأمّا كونه في معنى الإبراء، فإن اريد منه ترتّب براءة الذمّة عليه فهو مسلّم، ولكن لو أوجب عدم الخيار لكان شرط الخيار في بيع ما في الذمّة - أيضاً - باطلاً، ولا أظنّ أحداً ينكر صحّته.
وإن اريد كونه إنشاء الإبراء فالمنع ظاهر. فالأولى أنّ إناطة الحكم بالصحة والفساد على جريان التقابل فيه وعدمه، كما هو قضية الأصل المقرّر سابقاً.
ثم إنّ المحكيّ عن المبسوط(٣) والتذكرة(٤) دخول خيار الشرط في القسمة وإن لم يشتمل على الردّ وذلك اذا كان التراضي بالسهام، بالقول لا إشكال فيه، بناء على جريان التقابل فيها.
وأمّا اذا كان التراضي بالسهام بالفعل ففيه إشكال، لأنّ ارتباط القول بالفعل لا يخلو تصوّره من إشكال. والمعتبر من الشرط ما كان في متن العقد. ومنه يظهر الإشكال في جريان ذلك في المعاطاة.
____________________
(١) تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٨٦ س ١.
(٢) قواعد الاحكام: ج ١ - ٢ كتاب الضمان ص ١٧٧ س ١٠.
(٣) المبسوط: ج ٢ ص ٨٢.
(٤) تذكرة الفقهاء: كتاب البيع ج ١ ص ٥٢٢ س ٣٤.
قلت: إن كان المعتبر في صحة الشرط كونه في متن العقد صريحاً كان الاشكال متوجّهاً. وأمّا إن قلنا بكفاية التباني ووقوع العقد على ذلك البناء - بحيث يعدّ العقد عرفاً مقيّداً، بأن يكون الشرط المنويّ بمنزلة المحذوف من الكلام - فلا إشكال في الصحّة، لإمكان التباني قبل تسهيم المال بالسهام ووقوع التراضي، على أنّ ما يختاره أحدهما، أو كلاهما يكون اختياره له مبنيّاً على السلطنة على الردّ. ثم يجعل المال سهاماً، ويختار كلّ منهما سهماً بانياً على ما وقع عليه المقاولة. وكذلك الكلام في المعاطاة. والظاهر كفاية ذلك، لأنّ اعتبار ذلك ليس إلاّ لأجل أن يكون الإنشاء مقيّداً، وهذا المقدار كافٍ في تقييد الإنشاء.
ومنها: الصرف، فعن الشيخ(١) والغنية(٢) والسرائر(٣) عدم دخوله فيه مدعين على ذلك الإجماع. وعن الشافعي المنع، معلّل بأنّ الغرض من اعتبار التقابض فيه أن يفترقا، ولم يبق بينهما علقة، ولو اثبت الخيار بقيت العلقة.
وفيه: منع كون الغرض من اعتبار التقابض حصول الافتراق، مع عدم العلقة، بل الغرض عدم كون حقّ لإحدهما عند الآخر من العوضين.
وبالجملة: ان ثبت الإجماع - والظنّ خلافه - فهو، وإلاّ فالمتّبع هو العموم بعد القطع بجريان التقايل في العرف.
ومنها: المكاتبة المشروطة، بناء على أنّها من العقود، فعن جماعة - كما في المسالك -(٤) أنّه يجوز خيار الشرط للمولى. وعن الشيخ(٥) جوازه للعبد أيضاً.
وأمّا المطلقة: فظاهر المسالك(٦) الاتفاق على عدم دخوله فيه. والظاهر دخوله
____________________
(١) المبسوط: ج ٢ ص ٧٩.
(٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): ص ٥٢٥ س ٣٦.
(٣) السرائر: ج ٢ ص ٢٤٤.
(٤ و ٥) مسالك الافهام: ج ١ في الخيارات ص ١٨١ س ٦.
(٦) المبسوط: ج ٢ ص ٨٢.
فيها للمولى والعبد، لصحّة التقابل إن لم يثبت على خلافه إجماع، ولابدّ من التتبّع والتأمّل.
وأمّا القسم الثالث - وهو ما وقع الاتّفاق على دخوله فيه - فهو ما عدا ما ذكرنا، كما صرّح بذلك بعض المحقّقين من مشايخنا(١) – قدس سرهم -.
وأمّا الايقاعات: فالظاهر عدم الخلاف في أنّه لا يجوز شرط الخيار فيها. وقد ادّعى في المسالك(٢) الإجماع على ذلك صريحاً في العتق والإبراء. ويظهر منه الاتفاق - أيضاً - في الطلاق.
وعن المبسوط(٣) : نفي الخلاف عن ذلك في الإبراء، ويظهر من التعليل المحكيّ عن السرائر(٤) - لعدم دخوله في الطلاق، بأنّه من الايقاعات - أنّ ذلك من المسلّمات. وكيف كان، فقد استدلّ على ذلك بامور:
منها: أنّ المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين، كما ينبّه عليه الصحيح: من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللّه - عزّ وجلّ - فلا يجوز على الذي اشترط عليه(٥) .
وفيه: أنّ كون الشرط بين اثنين غير كونه بين الإيجاب والقبول.
نعم، إن قيل: إنّ الشرط في الإيقاع لا يفتقر الى القبول، كنفس الايقاع كان الوجه دفعه بذلك.
والحاصل: أنّ جريانه في الإيقاع ينافي افتقاره الى القبول، وذلك نظير شرط خدمة العبد عليه مدّةً معينةً في عتقه، إلاّ أن يقال: إنّ ذلك بالنسبة الى المشروط عليه كالشرط الابتدائي.
____________________
(١) جواهر الكلام: ج ٢٣ ص ٦٢.
(٢) مسالك الافهام: ج ١ ص ١٨١ س ٥ - ٤.
(٣) المبسوط: ج ٢ ص ٨٠.
(٤) السرائر: ج ٢ ص ٢٤٦.
(٥) وسائل الشيعة: ب ٦ من ابواب الخيار ح ١ ج ١٢ ص ٣٥٣.
وفيه: أنّه لا موجب لتخصيص العموم، لأنّ المسلّم خروجه هو الابتدائي من الطرفين.
ومنها: أنّه لا يصدق الشرط على ما وقع في ضمن الايقاعات. ويؤيّده المحكي عن القاموس(١) من أنّه: الالزام والالتزام في البيع ونحوه، ولا أقلّ من الشكّ إلاّ أن يتمسّك لإثبات صحّة الشرط بالعمومات، الدالّة على صحّة ذلك الإيقاع المقيّد بالشرط، بناءً على صحّة التمسّك بأفوا بالعقود، لصحّة العقد والشرط الواقع فيه بتقريب: أنّ الوفاء بالمقيّد هو العمل به على وجهٍ يطابق القيد، وستقف - إن شاء اللّه تعالى - على ما يبيّن به عدم دلالة تلك العمومات على صحّة هذا الشرط، ولو صحّ التمسّك بها لإثبات غير هذا لشرطٍ من الشرائط المقيّدة بها الإيقاعات.
ومنها: أنّ الإيقاعات آثارها رفع العلقة، وبقاء تلك الآثار معناه: استمرار عدم تلك العلقة ولا ريب أنّ العدم لا يرتفع إلاّ بمقتضى الوجود، والفسخ لا يكون مقتضياً لحدوث العلقة، بناءً على أنّ ذا الخيار بتلقي الملك من السبب السابق على العقد، لا من الذي فسخ العقد عليه.
توضيحه: أنّ الطلاق - مثلاً - أثره قطع علقة الزوجيّة، ومعنى استمرار هذا الأثر استمرار عدم الزوجيّة، وهذا العدم لا يرتفع إلاّ بمقتضى الوجود، وهو النكاح.
وأما الفسخ فليس مقتضياً للوجود، بل إنّما هو واقع فيما لم يكن له قابلية الارتفاع إلاّ بمقتضى الوجود، فليس مقتضياً لا يرتفع به.
ولعلّ هذا هو السرّ في إلحاق الصلح المقيّد فائدة الإبراء، أو إسقاط الحقّ بالإيقاعات، فأنّ أثره ليس إلاّ إبراء الذمّة من قدرٍ من المال، أو إسقاط حقّ من الحقوق، فلا يعود ذلك إلاّ بمقتضى العود، والفسخ لا يقتضي العود.
لا يقال: أثر البيع - أيضاً - إزالة الملك، واستمرارها استمرار عدم الملكية.
لأنّا نقول: أثر البيع ملكية المشتري للمبيع، وزوال ملك البائع ليس من آثار
____________________
(١) القاموس المحيط: ج ٢ ص ٣٦٨.
البيع، لأنّ معناه التمليك، وهو إدخال المال في ملك الغير، لا الإخراج وحده أو هو مع الادخال، وإنّما الخروج المحقّق من جهة عدم إمكان تأثير البيع مع عدمه، فاذا ارتفع أثر البيع - وهو الملكية - أثّر المقتضي لملكية البائع أثره، وانتقل المال إليه، ولكنّ هذا تقريب عقليّ، لا يمكن التمسّك في معارضة العمومات - على تقدير تماميّةٍ، وعدم منع بعض مقدماته - مع إمكان ذلك خصوصاً في العتق، لإمكان أن يقال: إنّ الحرّيّة صفة حادثة في العبد بواسطة العتق، فاذا ارتفع ذلك، وصار قابلاً لتأثير سبب الملك فيه أثّر مقتضيه فيه.
والحاصل: أنّ العبد بعد العتق حرّ، والفسخ يرفع هذه الصفة، فيصير كالكافر الذي لم يدخل تحت يد المسلم قابلاً للتملّك، فالمقتضي للملكية يؤثّر أثره، ونظيره باعتبار حالاته الثلاثة: الوقف، والمباح، والملك الفعليّ.
ومنها: أنّ تأثير الفسخ في الإيقاعات يمتنع، لأنّه يلزم منه إعادة المعدوم.
وفيه: أنّ المراد من المعدوم: إن كان هو العلقة المنقطعة بسبب الإيقاع فلا تختصّ الشبهة بالايقاعات، لأنّ العقد الحادث - كالبيع - كما تؤثّر الملكيّة للمشتري كذلك تؤثّر في رفع ملكيّة البائع.
غاية ما في الباب: أنّ ذلك في البيع بالملازمة، وفي الإيقاع بنفسه، وإن كان المراد منه: هو القابلية التي كانت في أحد طرفي العلقة - كالمالية في العبد التي كانت موجبة لصحة دخوله تحت الملك، وارتفعت بسبب العتق، بناء على أنّ أثر العتق خروج العبد عن المالية، وأنّ زوال الملك المولى عنه بسبب خروجه عن القابلية - ففيه أنّ أثر الفسخ رفع الحرية، وعدم القابلية. وانعدام المالية إنّما هو بسبب عروض هذا الوصف - أعني الحرية - فاذا ارتفعت يعود ذلك.
والمراد من العود: حدوثه بعد عدمه، والتسمية مسامحة، مع أنّ أصل الكلام لا يتمّ إلاّ في العتق، وفي الابراء بنوع من التكلّف، مع أنّ كون أثر العتق زوال المالية ممنوع؛ لجواز أن يقال: أثره زوال ملكية المولى، وعدم الماليّة بسبب عدم المالك، والمنع عن تملّكه، ولكنّه كلام سخيف، وأقوى الوجوه بعد ما مرّ من
الاتفاق المؤيّد بالشهرة، بل لعدم الخلاف عدم الدليل على الصحة - بعد ما عرفت سابقاً - من أنّ عموم (المؤمنون) ونحوه لا يدلّ على الصحة.
وأمّا التمسّك بعموم صحّة الإيقاعات فالكلام فيه هو الكلام في دلالة أدلّة الشروط، لأنّ معنى شرط الخيار: هو كون المشروط له مسلّطاً على رفع العقد، وتعلّق الخطاب بوجوب الوفاء بهذا الشرط بالمشروط عليه فرع إمكان حصول المعنى في الخارج، وصدوره من المشروط له، فاذا لم يقم دليل على إنشاءات المشروط له - المقصود بها رفع العقد - يؤثّر في ذلك، وكان مقتضى الأصل عدم التأثير لم يكن ذلك منه ممكن الحصول، فلا يكون الوفاء واجباً.
فتلخص: أنّ شمول قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) للعقد المشتمل على شرط الخيار، وكذلك شمول قولهعليهالسلام : (المؤمنون عند شروطهم) لشرط الخيار فرع معلوميّة تأثير الفسخ في رفع العقد، فإثباته بها لا وجه، بل يشبه الدور.
ودعوى أنّ معنى شرط الخيار هو السلطنة على رفع العقد عرفاً، وإنشاء الفسخ رفع له عرفاً، وإن لم يعلم كونه كذلك واقعاً، وعند الشارع فالتمكّن من رفع العقد حاصل، ووجوب الوفاء بالشرط يوجب الصحة. مدفوعة بالمنع من ذلك، وهو ظاهر، بل الشرط هو السلطنة على الرفع الواقعي.
غاية الأمر: أنّ إنشاء الفسخ سبب عند العرف لحصوله، والشارع له إمضاء ذلك، فيكشف ذلك عن مطابقة العرف للواقع، وله عدم الإمضاء، فيكشف عن خطئهم.
القول في خيار الغبن
وأصله الخديعة. وعن الصحاح(١) : أنّه بالتسكين في البيع، وبالتحريك في
____________________
(١) الصحاح: ج ٦ ص ٢١٧٢.
الرأي.
وفي اصطلاح الفقهاء: تمليك المال بما يزيد على قيمته، مع جهل صاحب الزيادة. ويسمّي آخذ الزيادة غابناً، ومعطيها مغبوناً.
وهو بالمعنى اللغويّ أخصّ منه بالمعنى الشرعيّ مطلقاً، لاعتبار علم الغابن في الأوّل، دون الثاني. بل لو لم يرد البيع في عبارة الصحاح - مثالاً - كان أوّله أخصّ من الثاني من هذه الجهة أيضاً.
ثمّ إن المراد بما يزيد: إن كانت الزيادة بملاحظة الشيء في نفسه كان البيع لشرط الخيار للمشتري، بما يزيد على قيمة المبيع في نفسه مشتملاً على الغبن، وإن كان مع الشرط لا يكون زيادة.
وإن كانت الزيادة بملاحظة الشيء، والقيود المأخوذة في العقد لم يكن مثل البيع المذكور مشتملاً على الغبن، والظاهر هو الثاني، لأنّ الشرط له قسط من الثمن، والمراد من الزيادة: ما لا يتسامح فيه الناس.
وهل هذا خارج عن الحكم أو عن الموضوع؟ وجهان: وظاهر هذا التعريف يؤيّد الأوّل.
وكيف كان، فالمشهور بين الأصحاب خصوصاً المتأخّرين - كما في المسالك(١) ثبوت الخيار للمغبون اذا كان غبنه بزيادة لا يتسامح فيها، ونسبه في التذكرة(٢) الى علمائنا، وعن نهج(٣) الحق نسبه الى الإماميّة، وعن الغنية(٤) والمختلف(٥) الإجماع عليه صريحاً.
ولكنّ المحكيّ عن كثيرٍ من المتقدّمين عدم ذكره والسكوت عنه، وعن المحقق
____________________
(١) مسالك الأفهام: ج ١ ص ١٧٩ س ١٨.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٢٢ قوله: البحث الرابع.
(٣) نهج الحق: ص ٤٨١.
(٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة): ص ٥٢٦ س ٢١.
(٥) مختلف الشيعة : ج ٢ ص ١٦٨ س ٣١.
إنكاره في الدروس(١) قبل، ولا يعدّ ذلك خلافاً كسكوت الجماعة.
قلت: أمّا الثاني فظاهر، لأنّه أعمّ من الخلاف. وأمّا إنكار المحقّق خصوصاً على الوجه الذي نقله في المسالك، حيث قال: وعن المصنّف في الدروس(٢) القول بعدمه، حيث يدلّ على استمرار رأيه عليه، فعدم كونه خلافاً مشكل، وإن كان موافقة المعروف في كتبه، وبما يشهد بأنّ إنكاره في الدروس لم يكن قولاً بالعدم.
واستشكل العلاّمة -رحمهالله - في التذكرة(٣) في ثبوته، مع بذل الغابن التفاوت. بل عن الرياض(٤) - حكاية القول بعدمه مع البذل، عن بعض الأصحاب، وعن الإسكافي(٥) منعه مطلقاً.
ولكنّ الإنصاف: أنّ مثل هذه الخلافات لا تضرّ بنقل الاتفاق المؤيّد بالشهرة العظيمة باتفاق المتأخّرين ظاهراً. ثمّ إنّه ما يستدلّ به أو يمكن الاستدلال به على ثبوت هذا الخيار امور:
الأوّل: قوله تعالى: (إلاّ أن تكون تجارةً عن تراض منكم)(٦) . كما استدلّ به العلاّمة -رحمهالله - في التذكرة، وقال: ومعلوم أنّ المغبون لو عرف الحال لم يرض(٧) .
قلت: لا ريب أنّ عدم الرضا التقديري لا ينافي حصول الرضا الفعليّ. وأيضاً
____________________
(١) نقلاً عن المكاسب: الخيارات، ج ١ ص ٢٣٤ س ٢٢ وفيه هكذا: نعم المحكّيّ عن المحقق (قده) في درسه انكاره. الخ، وعن الدروس: ص ٣٦٢ س ٢١ وفيه: وربما قال المحقّق في الدروس بعدم خيار الغبن.
(٢) مسالك الأفهام: ج ١ ص ١٧٩ س ١٨.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٢٣ س ١١.
(٤) رياض المسائل: ج ١ ص ٥٢٥ س ١٧ - ١٨
(٥) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٦٨ س ٢٩. لاحظ.
(٦) النساء، الآية: ٢٩.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٢٢ س ٤١.
عدم وجود الرضا. اذا صحّ لزمه عدم الصحة، لا الصحة مع عدم اللزوم كما هو المدّعى.
غاية الأمر أن لحوق الرضا - بناءً على عدم اعتبار مقارنته للعقد في الصحّة - يؤثر الصحّة مع اللزوم.
قال بعض المحقّقين من مشايخنا -رحمهمالله -: وتوجيهه أنّ رضا المغبون بكون ما يأخذه عوضاً عمّا يدفعه مبنيّ على عنوانٍ مفقودٍ، وهو عدم نقصه في المالية، فكأنّه قال:
اشتريت هذا الذي يساوي درهماً بدرهم، فاذا تبيّن أنّه يساوي درهماً تبيّن أنّه لم يكن راضياً به عوضاً، لكن لمّا كان المقصود صفةً من صفات المبيع لم يكن تبيّن فقده كاشفاً عن بطلان البيع، بل كان كسائر الصفات المقصودة، التي لا يوجب تبيّن فقدها إلاّ الخيار، فراراً عن استلزام لزوم المعاملة، إلزامه بما لم يلتزم ولم يرض به.
فالآية إنّما تدلّ على عدم لزوم العقد، فاذا حصل التراضي بالعوض الغير المساوي كان كالرضا السابق لفحوى حكم الفضوليّ، والمكره(١) . انتهى كلامهقدسسره .
ثم إنّه ضعّف ذلك بأنّ الوصف المذكور من قبيل الداعي الذي تخلّفه لا يوجب شيئاً، وليس عنواناً للمبيع، بل قد لا يكون داعياً - أيضاً - كما اذا كان المقصود ذات المبيع من دون ملاحظة مقدار ماليّته.
أقول: اذا كان الوصف عنواناً للمبيع كان كلّ من الإنشاء والرضا مقيّداً، فانتفاء الوصف يوجب انتفاء الإنشاء والرضا، لانتفاء المقيّد بانتفاء قيده، فانتقال العاري عن الوصف بالعوض يحتاج الى إنشاء ورضا جديد، ومجرّد كون الشيء من صفات المبيع لا يوجب تعلّق الإنشاء بالمطلق.
____________________
(١) نقلاً عن المكاسب: الخيارات ص ٢٣٤.
وعلى هذا فرضنا المغبون بعد الاطّلاع على الغبن بالمبادلة - أيضاً - لا يفيد الصحة، لأنّ ذلك ما لم يتحقّق تجارةً لا يكون مملّكاً.
فالآية - على تقدير تسليم كون مساواة المبيع في المالية للثمن عنواناً له يقتضي فساد المعاملة على تقدير انتفاء الوصف، وعدم كون الرضا اللاّحق مقيّداً، فالبيع المشتمل على الغبن أسوء حالاً من البيع الفضولي، حيث أنّه يصحّ بلحوق الرضا به لصدق التجارة عن تراض دون ما نحن فيه.
ودعوى أنّ تعلّق الرضا بالمقيّد ليس على وجهٍ ينتفي بانتفاء قيده، لأنّه على نحو تعدّد المطلوب، والرضا بالمطلق ليس على جميع التقادير حتى يوجب اللزوم، بل هو على تقدير كون البائع مسلّطاً على الردّ والإمضاء.
ولذا، يكون أكل المال ثابتاً على عدم الخيال أكلاً، بدون تجارة عن تراض، فلا يجوز بمقتضى الآية، والبناء يكون عليه تجارة عن تراض، ويكون الرضا المتأخّر - حينئذٍ - مؤثّراً في اللزوم، كما أنّه في البيع الفضولي مؤثّر في الصحة يدفعها أنّ ذلك - على تقدير تسليمه - لا يقتضي الصحّة بعد فرض تقيّد الإنشاء، لأنّ مقتضى الصحّة - كما مرّت الإشارة إليه - هو العقد، والرضا شرط، وما لم يتحقّق المقتضي لا يؤثر وجود الشرط شيئاً، مع أنّ هذا لا ينطبق على كلام المحقّق المذكور -قدسسره - فأنّ قوله: (فراراً عن إلزامه، لم يلزم ولم يرض به) ظاهره عدم الرضا بالمطلق.
إلاّ أن يقال: إنّ مراده: عدم الرضا على جميع التقادير، وهو بعيد عن مساق عبارته، فتأمل.
فإن قلت: المشخّص الموصوف اذا كان وصفه المأخوذ عنواناً، ممّا لا يتقوّم هو به لا يوجب فواته عدم صدق المبيع عليه، بل هو عند العرف مبيع، ولذا، يكتفون بالرضا المتأخّر في اللزوم، مع أنّ مقتضى النقل عندهم - أيضاً - هو العقد، فالعقد محقّق عرفاً.
قلت: الصدق العرفيّ مبنيّ على المسامحة، والمسامحة العرفيّة لا توجب تحقّق
المقتضى، الذي هو مناط الانتقال.
فالأولى أن يقال: إن أخذ الوصف في المبيع الشخصيّ عنواناً، مع عدم كونه من المقوّمات بمنزلة شرط الخيار، على تقدير فقدان الوصف، بمعنى أنّ قولهم: « بعتك هذا العبد الموصوف بكذا » مجمل، قولهم: « بعتك هذا على أن يكون لي الخيار إن لم يكن موصوفاً بكذا » وهذا هو المنشأ لصدق المبيع على فاقد الوصف عرفاً.
ولعلّ هذا، هو المراد من محكيّ النهاية(١) ، والمسالك(٢) من: أنّ الرؤية بمنزلة الاشتراط، فإنّ اشتراط الوصف في العين الشخصيّة لا محصّل له، وإن كان المراد - والشرط هو التعليق - فهو يوجب انتفاء الإنشاء عند انتفاء الوصف.
وتوهّم أنّ الخيار - حينئذ - ثابت بالشرط مدفوع بأنّ ذكر الوصف يؤول اليه عند التحليل، وإلاّ فالبيع بحسب الظاهر غير مقيّد بالخيار، وارد على العين الموصوفة ونرجوا من اللّه جلّ جلاله أن يأتي مزيد بتحقيق ذلك في بعض المسائل الآتية، إن شاء اللّه تعالى.
فانحصر الجواب فيما ذكره المحقّق المذكور -قدسسره - ومنع كون الوصف عنواناً وأنّه من قبيل الداعي، بل قد يتّفق أنّه لا يكون داعياً أيضاً.
الثاني: قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) بناء على أنّ أكل المال على وجه الخدع ببيع ما يساوي درهماً بعشرة، مع عدم تسلّط المخدوع بعد تبيّن خدعه على ردّ المعاملة، وعدم نفوذ ردّه أكل المال بالباطل.
أمّا مع رضاه بعد التبيّن بذلك فلا يعدّ أكلاً بالباطل، ومقتضى الآية، وإن كان حرمة الأكل حتى قبل تبيّن الخدع إلاّ أنّه خرج بالإجماع. وبقي ما بعد اطّلاع المغبون وردّه للمعاملة كذا قال شيخنا -قدسسره - في المكاسب(٣) .
____________________
(١) نهاية الاحكام: ج ٢ ص ٥٠١. المكاسب: الخيارات ص ٢٥٠ س ٥.
(٢) مسالك الافهام: ج ١ ص ١٧٥ س ٢٩.
(٣) المكاسب: الخيارات ٢٣٤.
أقول: حرمة أكل المال بالباطل لا تقبل التخصيص، فالإجماع كاشف عن عدم البطلان، وأنّ بناء العرف على بطلان بيع المخدوع، مع عدم السلطنة على الردّ خطأ منهم، فبعد الاطّلاع - أيضاً - كذلك.
ويمكن تقريب الاستدلال بوجهٍ آخر، وهو : أنّ العرف لا يحكم بمجرّد وقوع الخدع على بطلانه، بل هو عندهم موجب للسلطنة على الردّ، فأكل المال بعد الردّ - مستنداً الى هذا البيع - أكل بالباطل، لزوال البيع بالردّ.
ثم إنّه -رحمهالله - أورد على الاستدلال بأنّ ذلك معارض بقوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض) بناءً على أنّ التراضي حاصل في بيع المغبون، فمع التكافؤ يرجع الى أصالة اللزوم.
وأجاب عنه: بأنّ التراضي مع الجهل بالحال لا يخرج عن كون أكل الغابن لمال المغبون الجاهل أكلاً بالباطل.
قلت: ظاهر الجواب يساعد المعارضة، ضرورة أنّ مع خروج أكل الغابن في هذا الحال عن الأكل بالباطل بسبب التراضي، بكون آية التراضي حاكماً على آية حرمة الأكل.
ولو قلنا: إنّ قوله: (لا يخرج) غلط من الناسخ، وإنّ النسخة هي (يخرج) بدون كلمة (لا) فهو وإن اقتضى بطلان المعارضة إلاّ أنّه لا يتمّ معه الاستدلال، لما عرفت من أنّ آية التراضي - بناء على ذلك - حاكمة على أنّه حرمة الأكل، واللازم - حينئذٍ - تقديم الحاكم على المحكوم عليه.
والحاصل: أنّ آية التراضي - على تقديري - حكومتها على آية حرمة الأكل، وعدمها يبطل الاستدلال.
غاية الأمر، أنّ اللزوم ثابت على الأوّل بالآية، وعلى الثاني بالاصل. ويمكن أن يكون المراد من الجواب: أنّ آية التراضي لا تشمل مورد صدق الباطل، فما لم يكن التراضي مخرجاً للتجارة - عن كون الأكل مستنداً اليها أكلاً بالباطل - لا يصحّ التمسّك بالآية لإثبات الصحة.
ودعوى الاختصاص بما ذكر لعلّه مبنيّ: إمّا على ما علم من الخارج من أن الأكل بالباطل لا تتعلّق الرخصة به، وأنّ موارد الرخصة فيه بكون الرخصة كاشفةً عن عدم البطلان، وعلى أنّ استثناء التجارة عن تراض عن الأكل بالباطل استثناء منقطع قطعاً، وذلك يوجب اختصاص المستثنى بغير موارد تصادق التجارة عن تراض، والأكل بالباطل. فتأمل.
ولأجل ذلك أورد المعارضة - ثانياً - بوجهٍ آخر، فقال: ويمكن أن يقال: إنّ آية التراضي تشمل غير صورة الخدع، كما اذا أقدم المغبون على شراء العين محتملاً لكونه بأضعاف قيمته، فتدلّ على نفي الخيار في هذه الصورة من دون معارضة، فيثبت عدم الخيار في الباقي بعدم القول بالفصل، فتعارض مع آية النهي المختصّة بصورة الخدع الشاملة غيرها بعدم القول بالفصل، فيرجع بعد تعارضهما - بضميمة عدم القول بالفصل وتكافؤهما - الى أصالة اللزوم(١) .
قلت: مقتضى القاعدة ترجيح آية النهي لمطابقة مضمونها للشهرة العظيمة، والاجماعات المحكيّة. وذلك بناء على التزام التخصيص فيها - على تقدير تقديم آية التراضي - ظاهر.
وإن قلنا: إنّ آية التراضي واردة على آية النهي. وإن لم يكن التراضي مخرجاً للأكل بهذه التجارة عن الأكل بالباطل بناء على أنّ الإذن كاشف عن عدم البطلان واقعاً، وعن خطأ العرف في الحكم بالبطلان، فاللزوم - حينئذ - ثابت بمقتضى الآية. والبناء على التقديم بهذا الوجه إن صحّ فالمعارضة الاولى - أيضاً - سالمة عن المناقشة كما يظهر بالتأمّل.
ولكنّ الظاهر، أنّ المحقّق المذكور ليس نظره في المعارضة الى هذا الوجه، ولذلك أبطل الاولى ورجع الى الثانية.
الثالث: انّ النبيّصلىاللهعليهوآله أثبت الخيار في تلقّي الركبان، وانّما أثبته
____________________
(١) المكاسب: الخيارات ص ٢٣٤.
للغبن. وفيه منع صحّة الحكاية في نفسها، ولا جابر لها، لأنّه لم تنقل في كتب الأصحاب على وجه الاستناد حتى يكون ذلك موجباً للوثوق بالسند.
الرابع: وهو العمدة، قولهصلىاللهعليهوآله : (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)(١) وجه الاستدلال أنّ ذهاب مال المغبون بأقلّ من قيمته ضرر عليه، وهو لم يقدم على ذلك لجهله، فلو حكم الشارع - حينئذٍ - باللزوم كان الضرر حاصلاً من حكمه باللزوم. والحديث يدلّ على أنّ الإسلام ليس فيه ضرر ولا ضرار، فالحكم باللزوم الموجب له منع.
والحاصل: أنّ المراد: إمّا أنّ التديّن بدين الإسلام لا يترتّب عليه الضرر، ولا يوجب الإضرار بالغير. أو أنّ الحكم الذي يلزم منه الضرر أو الإضرار بالغير - وضعيّاً كان أو تكليفيّاً - ليس في الإسلام، ولا ريب أن ثبوت اللزوم في بيع المغبون ينافي كلا المعنيين، فهو منع.
فإن قلت: مقتضى الحديث ثبوت الخيار للعالم بالغبن - أيضاً - لأنّ اللزوم ضرر عليه كالجاهل به، وأيضاً الصحة ضرر كاللزوم فينبغي أن لا يكون بيع المغبون صحيحاً.
والحاصل: أنّ ذهاب مقدار من المالية بلا عوض ضرر، وعدم السلطنة على رفع هذا الضرر ضرر آخر. والحديث لا يختصّ بنفي ضررٍ خاصّ.
قلت: أمّا أنّ اللزوم ضرر على العالم بالغبن فيدفعه أنّ المنفي هو إيقاع اليدين أو حكم الشارع في الضرر، لا الحكم الذي يترتّب عليه الضرر وإن لم يصحّ الاستناد اليه. ولا ريب أنّ الزام المقدّم على الضرر بالالتزام ببيعه ليس إيقاعاً في الضرر عرفاً.
والحاصل: أنّ الإقدام على فوات المال بلا عوضٍ موجب لصحّة استناد الضرر إلى المقدّم، ومانع عن إسناده الى إمضاء الشارع. بل يمكن أن يقال: إنّ عدم
____________________
(١) عوالي اللئالي: ج ٢ ص ٧٤ ح ١٩٥.
الإمضاء هنا ضرر، لأنّه يقتضي سلب بعض أنحاء السلطنة على المال، فتأمّل. فأنّ الموجب لذلك عدم الإمضاء، بمعنى نفي الصحّة لا يفتقر بمعنى جعل الخيار. إلا أن يقال:
إنّ عدم التمكّن من إخراج المال عن المالك على وجهٍ لا يتمكّن من إعادته منافٍ للسلطنة المطلقة على المال، وهو غير سليم من نوعٍ من التكلّف. وأمّا أنّ الصحّة ضرر كاللزوم فيرد عليه.
أوّلاً: منع كون ذهاب المال مع السلطنة على ردّه ضرر عرفاً.
وثانياً: أنّ دلالة الحديث على نفي الصحة معارضة بالإجماع كما أنّ دلالته على نفي اللزوم مجبورة به.
فإن قلت: ضرر المغبون كما يندفع بجعل الخيار - بمعنى الفسخ في الكلّ - كذلك يندفع باسترداد المقدار الزائد على الثمن، ويبذل الغابن التفاوت بين ثمن المثل والمسمّى.
فالاحتمالات في رفع الضرر بعد ضمّ تخييره بين الثلاثة، وبين الاثنين منها الى تعيّن أحدها ينتهي الى ستّة، بل يزيد عليه، لاحتمال ترتّب الخيار على عدم البذل، أو عدم ردّ المقدار الزائد، كما ستأتي الاشارة اليه.
والحديث لا يدلّ إلاّ على انتفاء الضرر المحقّق بكلّ من الاحتمالات، فتعيين الخيار من بينهما يفتقر الى دليلٍ آخر.
قلت: أمّا استرداد المقدار الزائد فمع عدم إمكانه فيما لا يتبعّض، واستلزامه الضرر على الغابن لتبعّض المرجع عليه اذا كان هو المشترى، أو الثمن في عكس ذلك، ومقتضى الحديث نفيه يلزمه: إمّا الجمع بين العوض والمعوض، أو حصول المبادلة القهريّة.
بيان الملازمة: أنّ رجوع المقدار الزائد: إن كان مع بقاء صحّة المبادلة لزم الجمع بين الزائد، وما جعل عوضاً له من الثمن مثلاً.
وإن كان مع عدم بقائها فكون ما عدا المردود في ملك الغابن يحتاج الى سببٍ،
وهو منع، فلزم أن يكون بعد الخروج منه بالاسترداد داخلاً فيه - قهراً عليه - بلا سببٍ.
والحاصل: أنّ استرداد المقدار الزائد منافٍ للصحّة المجمع عليها، وأمّا بذل الغابن التفاوت بين ثمن المثل وثمن المسمّى فهو لا يوجب خروج المعاملة حقّ الغبن الموجب للخيار، لأنّه هبة مستقلّة.
كذا حكى الإيضاح(١) وجامع المقاصد(٢) . و يمكن المناقشة فيه: بأنّ البذل غرامة لما فات على المغبون - على تقدير لزوم البيع - فالضرر به مندفع.
وتوضيحه: أنّ الهبة المستقلّة لا تدفع الضرر، لأنّها نفع جديد حادث، وحدوث النفع بعد الضرر لا يوجب انتفاء الضرر، والبذل - هنا - ليس نفعاً جديداً، لأنّه بإزاء ما فات على المغبون.
لا يقال: إنّ ذلك يوجب سقوط الخيار ببذل المتبرّع أيضاً، مع أنّ كونه غرامةً ينافي الصحة، لأنّها تقتضي كون عوض مال المغبون هو العوض الجعليّ، لا غير، ومقتضى كون المبذول غرامةً أن يكون عوض ماله هو المجعول بضميمة المبذول.
لأنّا نقول: إمّا السقوط ببذل المتبرع فلا بأس به ولا مانع منه، وإمّا المنافاة للصحة فهي ممنوعة، لأنّ بذل التفاوت تدارك لما يلزم من صحة المقابلة الجعلية بين المختلفين في القيمة من الضرر، وهو فوات مقدارٍ من الماليّة، وذلك لا يقتضي كون عوض مال المغبون المجهول بضميمة المبذول، بل عند التأمّل يظهر أنّه يقتضي خلافه، فتأمّل فيه، فأنّه لا يخلو من دقّةٍ.
ويمكن الجواب بوجهٍ آخر، وهو أن يقال: المنفيّ بالحديث نفس الضرر، وهو ببذل الغرامة لا ينتفي، لأنّه تدارك له، فجعل اللزوم مع الغرامة ضرر مع التدارك، ومع الخيار لا ضرر أصلاً.
____________________
(١) ايضاح الفوائد: ج ١ ص ٤٨٥.
(٢) جامع المقاصد: ج ٤ ص ٢٩٤.
وتوضيحه: أنّ ذهاب المال الكثير بإزاء القليل، بحيث لا يتمكّن للمالك من ارتجاعه ضرر، لاستلزامه فوات مقدارٍ من المال بلا بدل. والخيار اذا ثبت انتفى هذا المعنى، وأمّا اللزوم مع البذل. فالضرر معه - حاصلاً - يمكن تداركه بأخذ المبذول، ومقتضى الحديث عدم جعل الضرر، لا عدم جعله بدون التدارك.
كذا أفاده السيّد الاستاذ - دام عمره وعزّه - وفيه نوع من التأمّل.
هذا كلّه في نفي احتمال البذل بأنحائه، ويرد على احتمال تعيينه أنّه ضرر على الغابن، لأنّه قد يتعلّق غرضه بشراء المال بدون قيمته، مع أنّه قد يقع في كلفة تحصيل المقدار المبذول، وهو ضرر آخر.
ومن هنا، اندفع ما يقال في ترجيح البدل على الخيار: بأنّ إلزام الغابن بالفسخ ضرر عليه، لتعلّق غرض الناس بما ينتقل اليهم من أعواض أموالهم، خصوصاً النقود، ونقض الغرض ضرر وإن لم يبلغ حدّ المعاوضة لضرر المغبون.
مع أنّه يرد عليه - أيضاً - بأنّ غرض المغبون قد يتعلّق بتملّك عين ذات قيمته، لكون المقصود اقتناءها للتجمّل، والتجمّل بذات القيمة اليسيرة مستنكف عنه.
وقد يجاب عن احتمال البذل باستصحاب الخيار معه.
ويرد عليه: أن ذلك يدفع احتمال التخيير بين الفسخ والبذل ابتداءً.
ولو قلنا: إنّ الفسخ مرتّب على عدم البذل، وإنّ الخيار يثبت على الممتنع، دون الباذل فلا مجرى للاستصحاب، لعدم ثبوت الخيار ما لم يمتنع الغابن عن البذل.
الخامس: بعض الأخبار الخاصّة كما عن الكافي بسنده الى إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّهعليهالسلام قال: غبن المسترسل سحت(١) .
وعن الميسرة عن أبي عبد اللّهعليهالسلام ، قال: غبن المؤمن حرام(٢) .
____________________
(١) فروع الكافي: ج ٥ ص ١٥٣ ح ١٤، وسائل الشيعة : ب ١٧ من ابواب الخيار ح ١ ج ٢ ص ٣٦٣.
(٢) فروع الكافي: ج ٥ ص ١٥٣ ح ١٥، وسائل الشيعة: ب ١٧ من ابواب الخيار ح ١ ج ٢ ص ٣٦٤ فيهما عن ميسّر.
وفي روايةٍ اخرى: لا تغبن المسترسل فإنّ غبنه لا يحلّ(١) . وعن مجمع البحرين: أنّ الاسترسال: الاستيناس والطمأنينة الى الانسان، والثقة به فيما يحدثه، وأصله السكون والثبات، ومنه الحديث: أيّما مسلمٍ استرسل الى مسلمٍ فغبنه فهو كذا، ومنه غبن المسترسل سحت(٢) .
قلت: إمّا دلالة ما عدا خبر ابن عمار فيمكن منعها، لاحتمال أن يكون المراد منها حرمة الخيانة في المشاورة، فيكون الغبن من الخديعة في الرأي.
وأمّا رواية ابن عمار فيرد عليه: أنّه يحتمل أن يكون المراد منها: أنّ الغابن بمنزلة آكل السحت في استحقاق العقاب على أصل العمل، وهي الخديعة في أخذ المال.
ويحتمل أن يراد: كون المقدار الزائد الذي يأخذه زائداً على ما يستحقّه بمنزلة السحت في الحرمة، والضمان.
ويحتمل أن يراد: كون مجموع العوض المشتمل على الزيادة بمنزلة السحت في تحريم الأكل في صورة خاصّةٍ، وهي اطّلاع المغبون، وردّه للمعاملة المغبون فيها. ولا ريب أنّ الحمل على أحد الأوّلين أولى، ولا أقلّ من المساواة للثالث فلا دلالة. كذا ذكره شيخنا في المكاسب(٣) -رحمهالله -.
قلت: مراده من حرمة الزيادة وضمانها: إن كان حرمة الأخذ، مع كونها بعد التملّك حلالاً، وضمانها بمعنى وجوب ردّ قيمتها إن طلبه المغبون، لينطبق على احتمال تعيين بذل التفاوت فلا ريب أنّه في غاية مخالفة الظاهر.
وإن أراد الحرمة حتى بعد الأخذ وضمانها - يعني وجوب ردّها أو بدلها عند التلف - فهو مخالف للإجماع، لأنّه قبل الاطّلاع على الغبن لا يجب دفع شيء.
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب ٢ من ابواب اداب التجارة ح ٧ ج ١٢ ص ٢٨٥.
(٢) مجمع البحرين: ج ٥ ص ٣٨٣.
(٣) المكاسب: الخيارات ص ٢٣٥.
وإن أراد ذلك بعد طلب المغبون، لينطبق على احتمال الفسخ في البعض فلا يقصر عنه المعنى الثالث. ولكنّك خبير بأنّ الدلالة لا تتمّ بتقليل الاحتمال.
مسألة: يعتبر في ثبوت هذا الخيار أمران:
الأوّل: جهل المغبون بالغبن. وتحقيقه: أنّ المغبون إمّا غير ملتفتٍ الى الغبن. أو ملتفت اليه، معتقد عدمه. أو ملتفت اليه وشاك فيه لا إشكال في ثبوته في الأوليين.
وأمّا الأخير: ففي ثبوته فيها إشكال: من أنّه مقدم على الضرر، لأنّ احتماله قائم لديه، والمقدم على محتمل الضرر مقدم على الضرر، ولذا يستحقّ اللوم والذمّ عند العقلاء. ومن أنّه لمّا كان بناء العقلاء على سلطنة المغبون على الردّ لم يكن البيع مع الشكّ في الغبن ما لم يكن مقراً(١) بالالتزام به على جميع التقادير، إقداماً على الضرر. والأقرب مع تسليم بناء العقلاء هو الأخير، ولا يبعد تسليمه.
وأمّا ما يقال: من أنّ الخارج عن عموم (لا ضرر) هو صورة العلم بالغبن، ففيه أنه مع تسليم الإقدام في صورة الشكّ لا وجه للتمسّك بالعموم، وليس عدم الخيار في صورة العلم تخصيصاً في حديث نفي الضرر، بل مع الإقدام لا مورد له، لان الضرر اللازم - حينئذٍ - ليس من حكم الشارع.
ولو أقدم على غبنٍ فبان أزيد، فإن كان الزائد لا يتسامح به فلا إشكال في ثبوت الخيار، لأنّه سبب مستقلّ في ثبوته، مع فرض عدم المزيد عليه، فمع وجوده أولى لتأكّده بالانضمام.
وإن كان ممّا يتسامح به، فإن لم يكن المزيد عليه ممّا لا يتسامح به لا منفرداً، ولا مع الانضام بالزيادة فلا إشكال في عدم الخيار.
وإن كان ممّا لا يتسامح به منفرداً، أو مع الزيادة ففي ثبوت الخيار وجهان:
من أنّ الزائد لا يكون سبباً، والمزيد عليه في حكم العدم للإقدام عليه.
____________________
(١) معترفاً (خ ل).
ومن أنّ البعض المقدم عليه هو البعض حال عدم الزيادة فمعها لا يكون مقدماً عليه، فهو: إن كان ممّا لا يتسامح به سبباً للخيار بنفسه يتأكّد بالزيادة. وإن لم يكن ممّا لا يتسامح كان المجموع سبباً لحصوله.
والحاصل: أنّ الغبن الحاصل لا يكون مقدماً عليه، ولا ممّا لا يتسامح به، فهو جامع لما يعتبر في إيجابه الخيار وهذا هو الأقوى.
الثاني: أن يكون النقص عن قيمة الشك حاصلاً حال البيع فحصوله بعده لا ينفع إثبات الخيار.
كما أنّ الزيادة بعده اذا كان النقص حاصلاً حاله لا يرفع الخيار، لأنّها حصلت في ملك المغبون، والمعاملة وقعت على الغبن. ويحتمل عدم الخيار، لأنّ الغرض منه تدارك الضرر، وقد حصل ذلك بالزيادة. ويدفعه أن ذلك ليس تداركاً، بل هو يشبه الهيئة المستقلّة.
وأمّا ما حكي عن العلاّمة(١) في خيار العيب من أنّه: اذا حصل الردّ قبل الردّ، سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده سقط الردّ، فيمكن الفرق بينه وبين ما نحن فيه، بأنّ سبب الخيار - هناك - هو العيب، وقد ارتفع، والخيار - هنا - سبب عن الضرر، وهو غير مرتفع، لأنّ الزيادة الحاصلة بكونها في ملك المغبون نفع جديد، فلا يكون ما حصل مرتفعاً.
ولكنّ ذلك فيما اذا كان العقد بنفسه مفيداً للملك. وأمّا اذا كان غير مفيدٍ له، وارتفع النقصان عند حصول شرط الإفادة - كالقبض - ففي ثبوت الخيار - هنا - اشكال، إذ معه لا يتحقّق الضرر، لأنّ المال لم يخرج عن ملك المغبون ما نقص من قيمته.
ومن هنا يشكل الحكم بثبوت الخيار قبل حصول القبض، ولو كان الغبن متحقّقاً، إذ لا يترتّب على اللزوم - حينئذٍ - ضرر من هذه الجهة. نعم، ذلك بناء
____________________
(١) المكاسب: الخيارات ص ٢٦١ س ٤، تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٤١ س ٢٣.
على ما نسب الى العلاّمة من إيجاب القبض في الصرف لازم، لأنّ إقباض المال بإزاء ما ينقص عن قيمته ضرر.
وأشكل من ذلك حصول النقص عن قيمة المثل بعد العقد، وقبل القبض، في مثل بيع الصرف لصدق الضرر، فهو يقتضي ثبوت الخيار، وذلك ينافي ما مرّ من عدم العبرة بالنقص بعد العقد.
والحاصل: أنّ مقتضى حديث نفي الضرر مراعاة الغبن، وجوداً وعدماً في حال الانتقال، التي هي في بيع الصرف زمان حصول القبض، ومقتضى التسالم على اعتباره حين العقد ينافي ذلك، فلا مناص: إمّا من تخصيص حديث الضرر، أو دعوى أنّ كلام القوم محمول على الاعتباريّة حال اجتماع شرائط الصحة، والعقد في مثل الصرف، قبل القبض لم تجتمع بعد شرائط صحته.
ولكنّه خلاف ظاهر معقد إجماع التذكرة، فأنّه قال: ولو كانتا - يعني الزيادة والنقيصة - بعده لم يعتدّ بهما إجماعاً(١) .
الثالث: أن يكون التفاوت فاحشاً، فمثل الواحد في العشرين، بل الاثنين لا يكون موجباً للغبن.
والمراد من الفاحش كما عن التذكرة: ما لا يتغابن الناس بمثله(٢) .
وحكى عن المسالك:(٣) أنّ التفاوت بالثلث لا يوجب الخيار، وإن كان باكثر من الثلث أوجه.
وأجاب عنه: بأنّه تخمين لم يشهد(٤) له أصل في الشرع(٥) انتهى. ولا ريب أنّ
____________________
(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٢٣ س ٦.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٢٣ س ٣.
(٣) كذا في المخطوط، ولم نعثر على ما يساوق الكلام من كتاب المسالك، والظاهر أنّه « مالك » كما ذكر مضمونه في التذكرة بعد قوله: « قال مالك ».
(٤) في المخطوط؛ « لم يشبّه »، والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٢٣ س ٩.
التفاوت بالثلث، بل الربع لا يتغابن الناس به، إنّما الإشكال في الجنس، ونفى البعد(١) عن عدم المسامحة له في المكاسب(٢) . وحكي التصريح عن المحقق القمي(٣) .
وهل المرجع عند الشك في كون التفاوت فاحشاً أصالة اللزوم، لأنّ عموم (لا ضرر) بعد اختصاصه بغير الفاحش لا يثبت الخيار فيما يشكّ في كونه فاحشاً ؟ بناءً على أنّ المرجع في الشبهات المصداقية هو الأصل الذي يقتضيه المقام، أو هو العموم، لأنّ الشبهة في المصداق ناشئة من إجمال المخصّص، مع دوران الأمر في المخرج عن العموم بين الأقل والاكثر، لأنّ عدم العلم بمقدار التفاوت الفاحش أوجب الجهل بكون هذا المقدار من التفاوت فاحشاً. والمرجع - حينئذٍ - هو عموم العام لسلامته بالنسبة الى الزائد عن المعارض، فيخصّص به الأصل، والعمومات المقتضية للزوم العقود. والأقوى هو الأخير.
مسألة: يسقط هذا الخيار بأمور:
أحدها: التصرف، وهو إمّا مانع عن رجوع العين كالبيع والاستيلاد، أو غير مانع عنه، وكلّ منهما، إمّا أن يكون قبل العلم بالغبن، أو بعده.
فنقول: أمّا التي لا تمنع رجوع العين فالظاهر أنّها إن كانت قبل العلم بالغبن لا تؤثّر السقوط، والظاهر أنّه مجمع عليه بين الأصحلاب. ولولاه لكانت المناقشة فيه، بناء على أنّ سقوط الخيار بالتصرّف لكونه مسقطاً في نفسه، لا لأنّه كاشف عن الرضا متوجّه.
إلاّ أن يقال: إنّ النصوص الدالّة على أنّ التصرف مسقط موردها خيار العيب والحيوان، وإلحاق غيرهما بهما أنّما هو بالاتّفاق المفقود هنا. فعدم الاتفاق كافٍ في عدم السقوط.
____________________
(١) في المخطوط: « النقد »، والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر.
(٢) المكاسب: الخيارات ٢٣٦ س ٢٨.
(٣) جامع الشتات: كتاب التجارة ج ١ ص ١١١ س ٢٥، المكاسب: الخيارات ص ٢٣٧. نقلاً عنه.
وإن كانت بعد العلم به فالظاهر أنّها مسقطة. وما يمكن الاستدلال به على ذلك امور:
أحدها: بعض معاقد الاجماعات من أنّ التصرف من ذي الخيار فيما انتقل اليه إجازة، وفي ما ينقل عنه فسخ.
قلت: انصرافه الى الجاهل بثبوت الخيار ممنوع، لأنّ الظاهر أنّ مناط الكلام هو كونه كاشفاً، ويعترف المغبون لا كاشفية له عن حصول الرضا بالضرر، والالتزام به لجواز أن يكون الالتزام منشأه توهّم كون الحكم الأصليّ هو اللزوم.
وثانيها: عموم التعليل في قولهعليهالسلام : (فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً فذلك رضا منه ولا شرط له)(١) بناء على أنّ المراد ليس تنزيل التصرف منزلة الرضا، أو الالتزام تعبداً، وأنّ المراد تعليل الحكم بعدم الشرط على تقدير الحدث بكون ذلك رضاً والتزاماً ولو بملاحظة نوعه. ولا ريب ان العلة تعميم الحكم بمقدار عمومها.
وفيه: أولاً: منع كون المراد من قوله: (فذلك رضاً) التعليل سلّمنا ذلك، ولكن كون الالتزام هنا مسقطاً في نفسه، لا لملازمة أمرٍ آخر - كحصول الإسقاط العرفي - ممنوع، لأنّ الدليل على ذلك: إمّا نفس الخيار بناء على أنّه السلطنة على الالتزام والفسخ، ولو لم يكن الالتزام مسقطاً لم يكن طرف الفسخ، بل كان الطرف ترك الفسخ.
وإمّا التعليل المذكور، ضرورة أنّ كون علة زوال الشرط بالتصرف كونه التزاماً يقتضي زوال الشرط متى حصل الالتزام وإن لم يكن تصرفاً.
والخيار بالمعنى المذكور لم يدلّ دليل على ثبوته للمغبون، لأنّ الضرر يندفع بالسلطنة على الفسخ، والشرط المنع بالتصرف المعلّل نفيه به بكونه التزاماً هو الخيار بذلك المعنى.
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب ٤ من ابواب الخيار ح ١ ج ١٢ ص ٣٥٠.
ولا ريب أنّ غاية ما يقتضيه هذا التعليل هو أنّ الالتزام متى حصل يزيل الشرط بذلك المعنى.
والحاصل: أنّ التعليل أنّما اقتضى أن يكون التصرّف التزاماً، فحيث لا حكم للالتزام لا يثبت له أيضاً حكم.
فإن قلت هنا: إنّ الالتزام في نفسه ليس مسقطاً، لكنّه يلزمه إسقاط الخيار، وهو مؤثّر.
قلنا: فالمسقط هو الإسقاط، ولزوم الاسقاط للالتزام المستكشف عن التصرف ممنوع، والملازمة بين إنشاء الالزام والإسقاط عرفيّة، بمعنى أنّ المفهوم من نحو ألزمت: هو الاسقاط، وإلاّ فمفهوم الالتزام أعمّ من الاسقاط، ويمكن حصوله بدون حصول الاسقاط.
اللّهمّ إلاّ أن يقال: إنّ الظاهر من الأصحاب أنّ الخيار الثابت هنا لا يغاير الخيارات الأصلية ذاتاً، وأنّ الفرق بينه وبينها أنّما هو خصوص كونه عرضيّاً، وكونها أصليّة، فسقوطها بالالتزام يلزمه سقوط ذلك به أيضاً.
والحاصل: أنّ الخيارات الأصلية: إن كانت بصفتها هي السلطنة على الفسخ، وعدمه كان عموم التعليل الدالّ على أنّ الالتزام مسقط، دالاًّ على كونه مسقطاً لهذا الخيار، لأنّ ذلك لا ينافيها بصفة.
وإن كانت حقيقتها السلطنة على الفسخ والالتزام كان دليل الضرر بمعونة اتفاق الأصحاب على عدم الفرق بين هذا الخيار، وغيره مثبتاً لتلك الحقيقة للمغبون. وقد عرفت أنّ الحكم بثبوتها يقتضي كون الالتزام مسقطاً، فتأمّل.
وثالثها: أنّه لا دليل على ثبوت الخيار بعد التصرف الكاشف عن الالتزام، لأنّ الدليل عليه: إن كان هو الاتفاق فهو مفقود، وإن كان حديث الضرر فما يقتضي عدم شموله للمقدم على الضرر يقتضي عدم شموله للملتزم أيضاً.
وبالجملة: الإقدام والالتزام يشتركان في أنّه مع حصولهما يصدق على الحكم باللزوم أنّه حكم ضرري صدر من الشارع، وأنّه يصحّ معهما أن يستند الضرر الى
فعل المغبون.
ومن هنا علم، أنّه لا وجه لاستصحاب الخيار، لأنّ موضوعه - وهو عن الملتزم بالضرر - منتفٍ بعد الالتزام، بل الشكّ في كون الموضوع ما يبقى بعد الالتزام، أو يرتفع كافٍ في عدم صحّة الاستصحاب. فانقدح أنّه لا وجه للاستصحاب - أيضاً - على تقدير كون المستند في ثبوت الخيار هو الاتفاق، لاحتمال أن يكون موضوع الحكم المتّفق عليه ما يرتفع بالالتزام.
وفيه: بعد منع كون التصرف من الجاهل بالخيار التزاماً بالضرر، لاحتمال أن يكون ناشئاً من اعتقاد عدم التمكّن من الردّ أنّ التصرف لا يوجب القطع بالالتزام.
نعم، لو دلّ دليل على أنّ ظهور التصرف في حصول الالتزام كافٍ في الحكم بثبوته تعبّداً كعموم التعليل بتقريب أنّ الحكم بكون التصرف التزاماً، مع إمكان التخلّف يلزمه اعتبار الظهور النوعي كان عدم شمول الحديث للملتزم كافياً في الحكم بعدم الخيار، ولو بمعونة استصحاب بقاء أثر العقد بعد فسخ المغبون الملتزم.
الاّ أن يقال:
إنّ الشكّ في حصول الالتزام كافٍ في الحكم بعدم الخيار، لأنّ أصالة عدم الالتزام لا يثبت الخيار، لأنّ مقتضى الحديث ارتفاع اللزوم، حيث ما لو نفي صدق عليه أنّه إضرار من الشارع، وهذا عند عدم الالتزام ليس من أحكامه الشرعية.
كما لا يخفى بقي - هنا - أمر ينبغي التنبيه عليه، وهو أنّ مقتضى قولهعليهالسلام : (فذلك) يعني أنّ التصرف التزام نوعي، ولا ريب أنّ ذلك بالنسبة الى الجاهل بالخيار قابل للمنع، حتى في الخيارات الأصلية.
ويمكن الجواب عنه: تارةً بأنّ الجهل بثبوت الخيار، واعتقاد اللزوم يصير داعياً للالتزام، والتصرف في المبيع، فالالتزام حاصل. غاية الأمر: أنّ الداعي لذلك هو الجهل.
واخرى بأنّ الحكم بكون التصرف التزاماً أنّما هو بالنظر الى ذاته، مع قطع النظر عن الحكم الشرعي. ولا ريب أنّ بناء العرف والعادة ما لم يكن بناءهم على
الالتزام بالعهد على ترك التصرف، ولو رد واحد المبيع بعد التصرف أحياناً بعد تصرفه، مانعاً من سلطنته على الردّ. ويلازم(١) على الردّ في هذه الحالة - وما سبق - من منع كون التصرف من الجاهل التزاماً، أردنا به أنّه ليس التزاماً حقيقةً على وجهٍ يصحّ معه سبب الاضرار عن الحكم باللزوم. وهذا لا ينافي كونه التزاماً بهذا المعنى، فتأمل.
وأمّا التصرف المانع عن رجوع العين، فإن كان بعد العلم بالغبن فهو كغيره، بل هو أولى بسقوط الخيار به، وإن كان قبله فالمحكيّ عن المشهور(٢) إسقاطه الخيار، وفي الحكاية نظر؛ ففي نفي القول به عن من سبق على المحقّق.
وكيف كان؛ فاستدلّ العلاّمة -رحمهالله - في التذكرة(٣) - كما حكي - بأنّه لا يمكن استدراك الخيار مع فوات العين، وهو بظاهره مع عدم إناطته الخيار بإمكان ردّ العين مشكل.
وقد يوجّه بأنّ حديث الضرر لا يثبت إلاّ السلطنة على ردّ العين وجه ضرر المغبون بلزوم البيع - حينئذٍ - معارض بضرر صاحبه بإلزامه بقبول البدل، مؤيّداً بأنّ نقل العين التزام من المغبون بالبيع وإن جهل بالغبن.
والجواب: أنّ لزوم البيع بعد عدم إمكان الردّ - أيضاً - ضرر، والتصرف مع الجهل كيفما كان لا يكون التزاماً بالضرر، فلا مخصّص للحديث بصورة إمكان ردّ العين، والمعارضة ممنوعة، لأنّ ردّ المثل على الغابن لا ضرر فيه، وكذا ردّ القيمة على تقدير كون ملك الغابن قيميّاً، لأنّ تعريضه للبيع كاشف عن إرادة القيمة.
قلت: مجرّد التعريض للبيع لا يدلّ على الإعراض عن الخصوصيّة، خصوصية العين والرضا بكلّ ما كان بدلا له فقد يكون الغرض من التعريض تحصيل عوض
____________________
(١) يلام. (خ).
(٢) المكاسب: الخيارات ص ٢٣٩.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٢٣ س ١٣.
خاص ولو بحسب المالية.
نعم، بيعه يدلّ على الإعراض عنه في مقابلة البدل المسمّى، وهو لا يفيد، مع أنّ هذا أنّما يسلّم فيما لو كان الغابن هو البائع، ولو كان المشتري فالمنع أقوى، لأنّ دلالة المعاوضة الخاصّة على الإعراض عن الخصوصية - مطلقاً - معلومة العدم، ولا تعريض منه غير ذلك فيدّعي دلالته على الاعراض عن الخصوصية.
والحاصل: أنّ البائع لكونه غالباً طالباً للبيع، وواضعاً لمتاعه في محلّ طلب الناس لحوائجهم يمكن أن يقال: إنّه معرض عن الخصوصية مطلقاً، وليس هكذا المشتري، لأنّ الغالب فيه بالعكس.
فالأولى أن يقال: إنّ ضرر المغبون ماليّ، وضرر الغابن إن كان فهو باعتبار مخالفة المردود اليه لغرضه، وعند التعارض بينهما يقدّم الأوّلي، لأنّه أقوى بحسب نوعه، مع أنّه قد يكون المغبون مغروراً من الغابن، فلا يعارض ضرر المغبون بضرره.
ثم إنّه قد يفرّق: بين ما لو كان المغبون المشتري فليس له الردّ مع التصرف الناقل، وبين ما لو كان البائع فله الردّ، وهو مشكل، لأنّ قضية التعليل عدم الفرق، بل التأمّل في بعض ما سبق يقضي بأولويّة الحكم في طرف البائع.
نعم، لو كان سند المنع هو الإجماع، وادّعى إمكانه في طرف البائع كان الفرق وجيهاً.
وبالجملة: مقتضى التعليل بعدم إمكان الاستدلال عدم الفرق بينهما، كما أنّ مقتضاه عدم كون الناقل الجائز مسقطاً.
غاية الأمر: أنّ الفسخ قبل الرجوع الى العين لا يؤثّر، لأنّه لا يستدرك به الضرر، لأنّه لا يقتضي ردّ العين.
فمعنى بقاء الخيار: سلطنة المغبون على الفسخ بعد الرجوع، ومقتضاه - أيضاً - عدم الفرق في سقوط الخيار بين أقسام موانع الردّ من كونه مخرجاً للملك، أو فكّاً له كالعتق والوقف إمّا مانعاً عن التلقي من المغبون كالاستيلاد، أو كونه فقد العين كما لو تلف المبيع قبل العلم بالغبن، ولو زال المانع كما لو مات ولد امّ الولد، أو
انفسخ العقد، ففي عود الخيار، وعدمه وجهان:
من أنّ الضرر يمكن تداركه، ومن أنّ اللازم لا ينقلب جائزاً، وفيه منع، ولو عاد المبيع الى المغبون بعقدٍ جديدٍ ففي عود الخيار إشكال، حيث أنّ الفسخ لا يقتضي ردّ المبيع، لأنّه يقتضي زوال ملك المغبون المستند الى العقد الأوّل، لأنّه رفع له دون ملكه المستند الى العقد الثاني، وإمكان ردّ العين في الخارج لا يؤثّر في الخيار، لأنّ الظاهر أنّ المراد الاستدراك بالفسخ، وبه لا يستدرك.
اللهمّ إلاّ أن يمنع ذلك بأن يقال: إنّ قضية الفسخ إبطال العقد، ومقتضاه رجوع العين أو الأقرب اليه من إبداله. ورجوع العين - هنا - وإن لم يمكن بالأصالة ولكن ممكن بمقتضى الأقربيّة.
والحاصل: أنّ مناط الرجوع الى البدل يوجب الرجوع الى العين، ويؤيّده ما قيل بجواز ردّ العين المفترضة أداءً، مع أنّ ما في الذمّة هو المثل أو القيمة نظراً الى أنّه أقرب منها، فتأمل.
وفي لحوق الإجارة لامتناع الردّ وعدمه، لأن المستثنى هو التصرف المخرج وجهان، بل قولان:
قلت: إن اريد من امتناع الانتقال بالفسخ فالمنع ظاهر، وإن اريد امتناع التسليم لكونه تجب سلطنة المستأجر ففيه: أنّ الظاهر أنّ المراد عدم إمكان الاستدراك، لعدم قابلية العين للردّ بالفسخ الا أن يقال:
انّ المراد: عدم إمكان الاستدراك بالفسخ، إمّا لعدم اقتضائه انتقال العين من المغبون الى الغابن، أو لعدم اقتضائه - بعد الانتقال - سلطنة الغابن على تسليم العين.
ومن هنا انقدح أنّه لو كان الاطّلاع على الغبن بعد انقضاء مدّة الأجارة، أو انفساخها فلا إشكال في ثبوت الخيار، وكذا لو كان الاطّلاع عليه بعد انفساخ العقد اللازم الناقل للعين، لأنّه لا يستلزم الخيار انقلاب اللازم جائزاً، ولو كان بعد العود بنقلٍ جديدٍ فالإشكال في ثبوت الخيار بحاله، كما يدعو اليه التأمّل فيما سبق.
ولو كان التصرف بالامتزاج فلا ردّ، ولو لم يكن الامتزاج موجباً لإلحاق العين
بالتالف، لأنّ معه - لحصول الشركة بعد الانفساخ ورجوع العين الى الغابن في المال الممزج - لا يمكن تسليم العين، بل يمكن أن يقال:
إنّه لا يمكن الرجوع الى الغابن بالفسخ، لخروج العين بالامتزاج عن قابلية الانتقال على غير نحو الإشاعة، بناء على أنّ الشركة الحاصلة بالامتزاج واقعة قهرية، لا ظاهرية، لأنّه يستفاد من ذلك أنّ الامتزاج مانع عن تعلّق الملك بالعين على وجه التميّز، فتأمل.
ولو تغيّرت العين بالنقيصة الموجبة للإرش فكذا لا خيار، لامتناع الاستدراك بردّ العين، وكذا لو تغيّرت بالزيادة، فإن اوجبت الشركة فلا خيار، وبدونه فلا مانع منه. ولعلّه تأتي الإشارة الى أقسامها عن قريب، إن شاء اللّه تعالى.
وهذا كلّه في تصرف المغبون، وأمّا تصرف الغابن فلا وجه لسقوط الخيار به.
وعليه، فلو كان ناقلاً فهل للمغبون إبطاله من حينه، أو من أصله، أو لا لا يكون له إلاّ الرجوع الى البدل؟ وجوه:
والدليل على الأوّل: إمّا على ثبوت الخيار فهو أنّ العقد وقع في متعلّق حقّ المغبون، وكان ظهور الغبن كاشفاً عن تحقّقه، وسبباً لظهوره، فله الخيار في الاسترداد قضاءً لحقّه. وإمّا على عدم البطلان من رأس فهو أنّ العقد وقع في ملك الغابن باختياره، فالعلّة التامّة للانتقال - وهي العقد والرضا - متحقّقة.
وعلى الثاني: منع حصول العلّة التامّة لتوقّف صحّة العقد الواقع على متعلّق حقّ الغير على رضاه، مقارناً أو لاحقاً، وفسخ المغبون بمنزلة الردّ له.
ولذا كان بيع الرهن كالفضوليّ، موقوفاً على رضا المرتهن على أنّه لو كان صحيحاً كان لازماً، لأنّ فسخ المغبون أنّما يقتضي تلقّي الملك من الغابن، دون المشتري. إلاّ أن يقال: إنّ فسخه يوجب خروج العين عن ملك المشتري الى ملك الغابن أيّاً ما، فينتقل الى ملك المغبون.
وعلى الثالث: منع ثبوت الحقّ للمغبون، إمّا لأنّ حقّه يحدث بعد ظهور الغبن، أو لأنّ تصرفات من ليس له الخيار في زمان الخيار صحيح لازم، بناء على عدم
اقتضاء الخيار بثبوت حقّ في العين، بل هو ملك فسخ، وقبضه مع بقاء العين على ملك الغابن رجوعها، ومع عدمه رجوع البدل، إمّا لأنّ المبيع ينتقل الى البائع تالفاً فيستحق بدله من تالفه، أو لأنّ الرجوع الى البدل بعد الانفساخ من أحكام الفسخ، شرعاً أو عرفاً.
وأمّا ما كان فلا وجه للخيار، لمعنى سلطنة استرداد العين بعد حصول النقل اللازم، ومحلّ إشباع الكلام في هذا المقام باب الأحكام.
والظاهر أنّ الاستيلاد والعتق كالنقل اللازم. ولكنّ الوجه الأوّل لا يتأتى في العتق، وما في معناه(١) من العقود والايقاعات التي لا تقبل الانفساخ فالمتعيّن فيها: إمّا البطلان من رأس، أو اللزوم.
وربّما يحتمل في خصوص الاستيلاد ثبوت الخيار لسبق على الاستيلاد، والفارق بينه وبين الناقل اللازم غير معلومٍ. والظاهر أنّ العقد الجائز كاللازم في الوجوه السابقة. هذا كلّه في العقد اللازم.
وأمّا الجائز، فالظاهر أنّه كذلك تتأتى فيه الوجوه الثلاثة، وذلك في الأوّلين ظاهر، وكذا على الأخير، لأنّ قضية الفسخ الرجوع الى العين اذا كانت في ملك المفسوخ عليه، وجواز العقد المتخلّل بين عقد المغبون، وفسخه يقتضي سلطنة الغابن على الرجوع، دون غيره، بل لو فرضنا أنّ جوازه يوجب سلطنة المغبون لم يكن مجرّد الفسخ المتعلّق بالعقد الأوّل رافعاً للعقد الجائز، لما عرفت أنّ صحّة الفسخ لا تتوقّف على إمكان رجوع العين.
ومن هنا علم، أنّه لا يلزم - على الوجه الأوّل من الوجوه المتقدّمة في العقد اللازم من انفساخ العقد الأوّل - إنفساخ العقد الثاني، وكون حقّ المغبون - أوّلاً وبالذات - متعلّقاً بالعين لا يقتضي إلاّ السلطنة على استرداد العين، وفسخ العقد الأوّل إنّما يكون استرداداً للعين اذا كانت العين في ملك المفسوخ عليه.
والحاصل: أنّ خيار المغبون أوجب تزلزل العقد الواقع على متعلّق خياره، وهو
____________________
(١) في المخطوط: معناها، تصحيف.
إنّما يوجب البطلان اذا صدر منه ما يوجبه. وفسخ العقد الأوّل بنفسه لا يوجب بطلان الثاني، فمعنى تزلزل سلطنة المغبون على إبطاله فلو قصد بفسخه إبطال العقدين كان مقتضاه رجوع العين اليه.
وبالجملة، غاية ما دلّ عليه دليل الوجه الأوّل: هو عدم ارتفاع سلطنة المغبون على استرداد العين بنقل العين، وهو إنّما يوجب كون النقل متزلزلاً، وكونه مفسوخاً بفسخ العقد الأوّل فلم يثبت بذلك، وإنّما يثبت ذلك اذا تبيّن أنّ حقيقة الفسخ توجب الرجوع الى العين.
وهذا ليس من مقتضيات ما ذكر دليلاً. وعن المسالك: لو كان الناقل مما يمكن إبطاله - كالبيع - بخيار بالفسخ، فإن امتنع فسخه الحاكم، وإن امتنع فسخه المغبون(١) - انتهى.
أقول: إن أراد من ذلك الإلزام بعد فسخ المغبون ففيه: أنّ فسخ المغبون للعقد الأوّل إن أثّر في إبطال ذلك فلا حاجة الى ما ذكر، وإن لم يؤثّر كان مقتضاه رجوع البدل اليه، ومعه لا وجه لإبطال العقد الثاني، وأخذ العين بعد تملّكه للبدل.
ودعوى أنّ ملكه للبدل أنّما كان للحيلولة فلا ينافي سلطنته على استرداد العين. مدفوعة بأنّ الحيلولة أنّما تتصور اذا كانت العين ملكاً للمغبون، وصار الغابن حائلاً بينه وبين ماله.
وإن أراد من ذلك إلزامه قبل فسخ المغبون ففيه: أنّ خيار المغبون متعلّق بنفس العقد، وليس له حقّ في العين، ولو فرض حقّ في العين كان مقتضاه سلطنته على الفسخ، ولا وجه للرجوع الى الحاكم بعد امتناعه، بل لم يكن وجه لإلتزام الغابن بالفسخ أيضاً.
وبما ذكرنا علم، أنّه لو عاد الملك الى الغابن بفسخ العقد الجائز فإن كان بعد فسخ المغبون فلا رجوع له اليه، لأنّه استحقّ البدل بالفسخ. وإن كان قبله استحقّه بالفسخ، ولو عاد اليه بملكٍ جديدٍ فالظاهر عدم استحقاق المغبون له مطلقاً.
____________________
(١) مسالك الأفهام: ج ١ ص ١٨٠ س ٦.
أمّا اذا كان العود بعد فسخه فظاهر، وإن كان قبله فلأنّ فسخ المغبون أنّما يوجب استحقاقه بالسبب السابق على عقده بسبب ارتفاع العقد، وفسخه لا يوجب ارتفاع الناقل الجديد.
ويحتمل العود لا المغبون، نظراً الى ما أشرنا اليه سابقاً في فروع تصرفات المغبون من إمكان رجوع العين للأقربيّة، وإن لم يمكن رجوعه بنفس الفسخ.
وإن كان التصرف غير ناقل للعين فإمّا أن يكون نقلاً للمنفعة أو مغيّراً للعين.
أمّا الأول: فكما لو أجّر العين. وهل تنفسخ الإجارة بفسخ العقد أو تنتقل العين الى المغبون مسلوب المنافع؟ وجهان، بل قولان:
حكي الأوّل عن المحقّق القميّ -قدسسره - حجّة القول الأوّل: أنّ ملك منفعة الملك المتزلزل متزلزل، وأنّ فسخ المغبون كاشف عن عدم كون الغابن مالكاً للمنافع الحادثة بعد الفسخ(١) .
أقول: مقتضى ظاهر الوجه الثاني انفساخ الإجارة من حين انفسخ، بل يمكن أن يقال: إنّ مقتضاه عدم صحتها بالنسبة اليه، فإن كان فسخ البيع ردّاً وإلاّ أمكن صحّتها بالإجارة. ومقتضى الوجه الثاني صحتها، وسلطنة المغبون على إبطالها من رأس بإبطال البيع.
فالتنافي بين الوجهين من وجهين: أحدهما: اقتضاء الثاني البطلان بالنسبة الى ما بعد الفسخ. والأوّل صحته مطلقاً.
والثاني: أنّ الأوّل يقتضي الانفساخ من رأس بفسخ البيع، والثاني انفساخه من حيث العقد. اللهمّ إلاّ أن يدفع الثاني بأنّ المراد من تزلزل ملك المنفعة: أنّ ملك المنفعة ما لم يحل زمانها قابلة للزوال بزوال ملك العين اذا كان ملك العين متزلزلاً.
وكيف كان، يرد على الوجه الثاني: أنّ ملك منافع العين بالغ لملكها آناً ما. ولذا حكم بأن بيع العين المستأجرة نقلها مسلوبة المنافع.
____________________
(١) المكاسب: الخيارات ص ٢٤٠.
لا يقال - على هذا- : يجب القول بأنّ تمام منافع العين ملك للطبقة الاولى، فتصحّ إجارتهم لها مدّةً تزيد على مدّة بقائهم.
قلت: ليس تلقّي الطبقة الثانية الملك من الاولى.. ، بل هو من الواقف، وسبب النقل اليهم منه يقتضي ملك المنافع.
لا يقال: زوال ملك الغابن من العين بزوال سببه. وملك المغبون مستند الى السبب الأوّل، فهو ليس متلقّياً له من الغابن.
لأنّا نقول: ليس مناط الفرق مجرّد التلقي من غير مالك العين، بل المناط اقتضاء سبب ملك المالك الثاني انتقال العين غير مسلوب المنافع اليه، والسبب الأوّل - هنا - الموجب لملك المغبون للعين لا يقتضي ملكه لها غير مسلوب المنافع.
ويرد على الأوّل: أنّ التزلزل يحتاج الى دليلٍ، وأصالة بقاء المنافع في ملك مالكها قبل الفسخ يقتضي عدمه، وأدلة الخيار تقتضي رجوع ملك العين بالفسخ، لأنّها لا تقتضي إلاّ السلطنة عليه لمقتضى رجوع العين خاصّة، على أنّ مجرّد تزلزل ملك المنافع لا يقتضي انفساخ الإجارة، بل قضية رجوعها إن أمكن، ورجوع بدلها على تقدير عدم الإمكان كتزلزل ملك العين، فعلى تقدير ثبوته تحت الرجوع الى آخره - مثل المنفعة - جمعاً بين دليل التزلزل، وبين دليل لزوم الإجارة.
ولكنّ الإنصاف أنّ الحكم بعدم استحقاق المغبون بعد الفسخ بشيء من المنفعة، فأجرة مثلها مع كون فوات المنفعة إصراراً - كما اذا كانت مدّة الإجارة طويلة - في غاية الإشكال.
وقد اعترف المحقّق الثاني(١) بالإشكال في حكم الأصحاب لعدم سلطنة الغريم على قلع الغرس، وعدم استحقاقه الاجرة بعد رجوعه اذا غرس المفلّس الارض، أو آجرها مدّةً طويلةً. والمسألة محتاجة الى التأمل.
واذا كان التصرف مغيّراً: فإمّا أن يكون التغيير بالنقيصة، أو بالزيادة، أو
____________________
(١) جامع المقاصد: ج ٥ ص ٢٨٥.
بالامتزاج.
أمّا الأوّل: فإن كان مما يوجب الإرش، بمعنى أنّه، لو اعتبر وجود الفائت في البيع كان عدم وجودها موجباً لاستحقاق الإرش - كوصف الصحة - كان الواجب ردّ الإرش، لأنّ الفائت مضمون بجزء من العوض، فرجوع تمام العوض الى الغابن يوجب رجوع الوصف إن كان، وبدله إن لم يكن وهو الإرش، ومثله فوات الجزء.
لا يقال: ضمان وصف الصحة بجزء من العوض ليس من مقتضيات العقد، بل استحقاق الإرش تقيّد شرعيّ.
لأنّا نقول: قد علم من بيع الموارد أن حكم وصف الصحّة حكم الأجزاء، ولذا يوجب فواته قبل القبض استحقاق الإرش، وإن لم يكن موجباً للإرش - مثل كتابة العبد - فالظاهر أنّه لا يستحقّ شيئاً، لأنّ الفسخ لا يوجب إلاّ رجوع ما يقابل الثمن الى البائع، وليس مثل وصف الكتابة مقابلاً للثمن، وكون ذلك سبباً لزيادة القيمة لا يقتضي مقابلة ذلك ببعض العوض، ومضموناً به ليقتضي الفسخ رجوع نفسه أو بدله، وان كان بالزيادة.
فيمكن أن يقال: إنّه لا شيء لمحدثها، لأنّ الزيادة الحاصلة ليست بمال مستقلّ يقابل بالمال، وليس عمل العامل بأمر المغبون ليكون مضموناً عليه.
والحاصل: أنّ كون الثوب مقصوراً ليس في نفسه مالاً يقابل بالمال، وليس حدوثه بأمر من المغبون ليكون عمل المقصّر مضموناً عليه.
ويحتمل الفرق بين ما اذا كانت الزيادة موجبة لزيادة القيمة، وبين ما اذا لم يكن كذلك بأن يقال: بحصول الشركة على الأقلّ دون الثاني.
أمّا الثاني: - فلما مرّ - من أنّه ليس عمل محدثها بأمر المغبون ليكون مضموناً عليه.
وأمّاالأول: فلأنّ الموجود مال تبعيّ، لأنّه يقابل بالمال تبعاً للعين، فبفوتها على محدثه لا وجه له.
لا يقال: المقابلة بين الموصوف والثمن إن كان بملاحظة الوصف، وكان الوصف
مقابلاً ببعض أجزاء الثمن كان الوصف مالاً، فيستحقّه محدثه.
ويشكل - حينئذٍ - ما سبق من أنّ الوصف ما لم يوجب الإرش لا يجب بفواته استحقاق القيمة، وإن كان الوصف موجباً لزيادة القيمة، كانت المقابلة بين ذات الموصوف والثمن.
غاية الأمر: أنّ الزيادة سبب لزيادة القيمة، لم يكن للرجوع الى الإرش وجه، لأنّ الوصف - حينئذٍ - ليس بمال تضمّن انماء وبدونه، فتأمّل.
قد تمّت هذه النسخة الشريفة على يد أقلّ السادات سيّد محسن الموسويّ الخوانساريّ سنة ١٣٢١ هـ.
رسالة في الاجارة
بسم اللّه الرحمن الرحيم
وبه نستعين
الحمد للّه رب العالمين، والصلاة على حبيبه محمّدٍ سيّد المرسلين وآله المعصومين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين الى يوم الدين.
قوله: (وكلّ موضع يبطل فيه عقد الإجارة).
أقول: المراد: أنّه تجب اجرة ما يستوفيه من المنفعة، كلاً أو بعضاً.
وتنقيح البحث في المسألة: أنّ الإجارة: إمّا على العين المملوكة كالدار، والعبد، وما أشبههما ممّا يقع تحت اليد كالوقف العامّ، وإمّا على الحرّ.
وعلى الأوّل: إمّا أن تكون المنفعة مقبوضةً، وإمّا غير مقبوضةٍ.
وعلى الثاني: إمّا أن يكون الحرّ صدر منه العمل، أو لم يصدر، صور أربع:
أمّا الصورة الاولى: فلا إشكال في أنّه لا ضمان فيها على المستأجر للأصل، بل القطع بعدم موجب للضمان.
كما أنّه لا إشكال في ضمان المستوفاة في الصورة الثانية لقاعدة اليد، واحترام مال المسلم، والاتلاف، ونفي الضرر، إلاّ أن يمنع شمول الأوّل للمنافع.
واقتضاء الثاني زيادة على حرمة التصرف بدون الإذن، وصدق الاتلاف على الاستيفاء، مضافاً الى إرسال المسألة إرسال المسلّمات.
وأمّا على تقدير عدم الاستيفاء ففي الضمان، وعدمه إشكال، وإن كان الأوّل
لا يخلو عن قوّةٍ لبعض ما سبق.
ويمكن بناء المسألة على ضمان الغير، المستوفاة من منافع المبيع فاسداً، إلاّ أن يفرّق بينهما من حيث الإقدام على الضمان، وقاعدة (ما يضمن)، فأنّهما يقتضيان الضمان هنا، وعدمه هناك، ولكنّه مشكل.
ثم إنّه لا يخفى، أنّ المراد من القبض ليس هو الموجب لسقوط ضمان المؤجر بتخلية يده عن العين، بل المراد: هو الاستيلاء عليها الموجب للاستيلاء على المنفعة.
و أمّا الصورة الثالثة : فالمعروف فيه الضمان أيضاً ، بل لم أعثر على مخالفٍ إلاّ ما يظهر من جامع المقاصد(١) في مسألة الاستثناء الآتية، إن شاء اللّه تعالى.
وكيف كان، فالظاهر هو المعروف لما دلّ على حرمة مال المسلم(٢) وعمله، فأنّ مقتضاه أن يكون الأمر المقدّم على ضمانه ملزماً بتداركه.
إلاّ أن يقال: إنّ العامل لم يخرج عن الاختيار، ولا يدخل عمل المسلم تحت اليد، لأنّ دخول المنفعة تحت اليد بتبعيّة العين لا يدخل في الفرض تحت اليد.
والحاصل: أن مقتضى حرمة العمل أن يكون المستوفي له ملزماً به، ومجرّد الأمر الغير المخرج للعامل عن الاختيار لا يجعل الآمر مستوفياً غايته. أنّه داعٍ للمأمور على العمل، ومجرّد عود نفع العمل الى الغير - أيضاً - لا يوجب الضمان.
ولذا، لو تخيّل أنّه أجير الغير فعمل، فبان خلافه، لا يحكم على الغير بالضمان، بل الجاهل بالفساد في فرض المسألة يرجع الى هذه الصورة حقيقةً.
ومن هنا تبيّن أن الأوجه: هو عدم الضمان، ولكنّ الإنصاف أنّ الالتزام بالعقد، والإقدام على المعاوضة تسلّم للعمل، واستيفاء له.
وتنقيحه: أنّ تسليم كلّ شيء، وتسلّمه بحسبه، وتسليم العمل الى الغير ليس إلاّ إيجاد العمل موافقةً لأمره، واعتماداً على إرادته. وتسلّمه هو الأمر به.
____________________
(١) جامع المقاصد: ج ١ ص ٤٢١ س ٢٦.
(٢) عوالي اللئالي: ح ٩٨، ج ١ ص ٢٢٢.
ولا ريب أنّ عقد الإجارة بعد اقتضائه التسليم والتسلّم - كما هو شأن عقود المعاوضات - أمر من المستأجر بالعمل، وقبول من الأجير للعمل، وبناء فيه على الموافقة.
فالعمل الجاري على العقل تسليم من الأجير، وبناء المستأجر على العقد، والتزامه به، وعدم ردعه الأجير تسلّم له.
بل يمكن أن يقال: إنّ الردع الصادر بعد العقد ما لم يكن رادعاً للأجر لزعمه صحة الإجارة، وكون المستأجر مبطلاً في ردعه لا يخرج المستأجر عن الالتزام فيه.
ومن بعض ما ذكرنا يظهر: أنّ الأظهر في الصورة الرابعة عدم الضمان، ودعوى أنّ مقتضى قاعدة (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) هو الضمان، لأنّ الأجير الخاصّ اذا سلّم نفسه للعمل، ولم يستوفه المستأجر الى أن انقضى زمان الإجارة يستحق الاجرة - كما يأتي إن شاء اللّه تعالى - مدفوعة بأن القاعدة لم ينعقد عليها إجماع، فالمتّبع في مواردها هو الدليل، ولا دليل - هنا - على الضمان، لأنّه: إمّا قاعدة اليد - وقد عرفت - أنّ عمل الحرّ لا يدخل تحت اليد، أو احترام العمل، وهو تابع لموضوعه المفروض انتفاؤه.
بل يمكن أن يقال: إنّه لا يلزم تخصيص في القاعدة أيضاً، لأنّ الحرّ لا يملك عمله، وأنّما هو مالك، لأنّ بملكه الغير، ودعوى أنّه يصدق عليه أنّه مال مدفوعة بأنّه قبل وجوده لا يكون العامل ذا مال عرفاً، بل هو بتحمّله كلفة الاشتغال يحصّل المال، والفرق بين عمل العبد والحرّ أنّ المولى لا كلفة له في أصل العمل.
ثمّ إنّ الشهيد(١) -رحمهالله - استثنى من الحكم بالضمان ما اذا كان الفساد ما اشترط عدم الاجرة في العقد، أو متضمّناً له كما لو لم يذكر اجرةً فأنّه - حينئذٍ - يقوى عدم وجوب الاجرة لدخول العامل على ذلك.
والظاهر، أنّ مراده من تضمّن عدم الاجرة ليس مجرّد عدم ذكرها في متن
____________________
(١) اللمعة الدمشقية: فيما لو اشترط عدم الاجرة في العقد ج ٤، ص ٣٣٥.
العقد، لأنّ ذلك أعمّ من الدخول على عدم الضمان، لإمكان بكون القصد الى تعيّنها بعد العقد، بل المراد منه أن يكون عدم الذكر ناسياً من التباني على عدم الاجرة، وإجراء بالعقد على ذلك البناء. وحينئذٍ، فالفرق بين الصورتين صراحة الاشتراط في الأوّل، وتضمّن العقد له على الثاني.
وتنقيح البحث: أنّه إن كان المقصود من الإجارة هو العارية، ويكون اعتبار عدم الاجرة قرينةً على إرادتها فلا إشكال في عدم الضمان وإن قلنا بفساد العقد، لأنّ (ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفساده) وكذا اذا كان المقصود هو الإجارة حقيقةً، إذ لا ريب في أنّه لا يمكن القصد الى مفهوم الاجارة، والشرط للتنافي إلاّ من الجاهل بالمنافاة لزعم أنّ الإجارة لا يعتبر فيها العوض، وعليه يكون الداخل على الإجارة داخلاً على ذهاب المال بلا عوض.
والفرق في ذلك بين ما اذا كان القصد الأصلي الى الإجارة، واعتبر عدم العوض لعدم المنافاة، وبين ما اذا كان ابتداء القصد الى التمليك بلا عوض لا وجه له، ضرورة أنّ الدخول على المجّانيّة حاصل على التقديرين.
ثمّ إنّه ربّما يفرّق في المسألة بين ما اذا كان مورد الإجارة منفعة العين محكم بالضمان، لأنّ اشتراط عدم العوض أنّما كان في العقد الفاسد، الذي لا أثر لما تضمّنه من التراضي فحقّه وجوب اجرة المثل، وما لو كان مورد الإجارة منفعة الأجير، فعمل بنفسه مع فسادها فالوجه عدم الضمان، لأنّه متبرّع بالعمل، وهو المباشر لإتلاف المنفعة.
وأورد في المسالك(١) على القسم الأوّل: بأنّ ذكر عدم الاجرة قرينة على إرادة العارية، وعلى الثاني: بأن التبرع أنما يتحقّق اذا عمل الأجير بناء على العقد.
أمّا لو أمره المستأجر بعد العقد فلا يكون متبرّعاً. فينبغي مع عدم ذكر الاجرة ثبوت اجرة المثل، كما هو شأن الآمر لغيره، فعمل من غير عقد.
____________________
(١) مسالك الافهام: فيما لو شرط عدم الاجرة في العقد ج ١، ص ٣٢٢، س ٢٨.
قلت: ويندفع الأول - مضافاً الى منع كون ذلك قرينةً على إرادة العارية - بأنّ ذلك خروج عن الفرض، إذ الكلام في قصد الإجارة.
والثاني بأنّ الأمر بعد العقد يرجع الى الآمر بالعمل بالقصد، وهو لا يؤثّر في وجوب اجرة المثل إن لم يكن الدخول في العقد الفاسد، موثراً فيه.
والإنصاف: أنّ الفرق بين الصورتين - أيضاً - مشكل، لأنّ الحكم ما بعد الضمان لم يكن لتأثير ما يضمنه العقد الفاسد من التراضي، بل هو إنّما لدخول المالك على التبرّع بالمال، ولذا حكموا بعدم ضمان المتّهب للعين الموهوبة فاسداً، حتى مع العلم بالفساد.
فإن قلت: عموم قاعدة اليد، والإتلاف يقتضي الضمان، ومجرّد الإقدام على المجّانيّة لا دليل على رفعه للضمان.
قلنا: هذا الكلام جارٍ بعينه في الهبة الفاسدة.
وتنقيح الجواب: أنّ عدم الضمان في الأمانات يقتضي العدم - هنا - بالأولويّة، لأنّ عدم الضمان - هناك - إمّا لتسليط المالك غيره على المال من غير تضمينٍ، أو لرفعه الضمان بالتلف دون الإتلاف، أو لكونه جاعلاً لغير المالك بمنزلة المالك.
وعلى جميع التقادير: يكون عدم الضمان - هنا - أولى منه في الأمانات، ضرورة أنّ عدم اعتبار الضمان، أو اعتبار عدمه على بعض التقادير، أو جعل الغير مالكاً تنزيلاً اذا كان واقعاً كان اعتبار العدم المطلق، وجعل الغير مالكاً تحقيقاً أولى بذلك، مع أنّه يمكن أن يقال:
إنّ استفادة عدم الضمان في الأمانات بأحد هذه الوجوه غير معلوم، والحكم في الهبة الفاسدة إجماعيّ.
الاّ أن يقال: إنّ مناط الحكم عند الأصحاب هو المجّانيّة الموجودة هنا، وليس حكمهم بذلك لظفرهم بتعبدٍ لم نظفر به.
والإنصاف: أنّ ذلك لا يخلو عن بعدٍ، بل هو قريب غايته.
بقي - هنا - إشكال ينبغي التنبّه عليه وهو: أنّ التبرّع بالمال اذا كان رافعاً
للضمان كان رفع اليد عنه - بشيء معينٍ - رافعاً للضمان بالزائد، لأنّه راجع الى رفع عن مقدار من الماليّة، وحينئذٍ فلا وجه لتعيّن اجرة المثل، بل الواجب هو أقلّ الأمرين من اجرة المثل والمسمّى. والجواب عنه:
أولاً: أنّ الفارق هو الإجماع، فأنّ تعين اجرة المثل إجماعيّ.
وثانياً: أنّ المالك لم يرفع يده عن عين ماله بلا عوض، وأنّما رفع يده عن مقدار من المالية، وربّما يكون لغرض لا يسلّم له، لفساد العقد بخلافه هنا، فأنّه رفع يده عن عين ماله بلا عوض، ولا دليل على أنّ رفع اليد عن مجرّد الأمر الاعتباريّ مؤثّر في تعيين البدل في أقلّ الأمرين.
قوله: (ويكره أن يستعمل الأجير قبل أن يقاطعه).
أقول: ليس المراد هو الإجارة، ضرورة أنّ صحّتها متوقّف على المقاطعة، بل المراد: أنّه يكره الأمر بالعمل من غير المقاطعة.
ويدلّ على ذلك: ما روي عن الصادق والرضا(١) سلام اللّه عليهما، وعلى آبائهما وأبنائهما الطاهرين.
قوله: (وأن يضمن إلاّ مع التهمة).
أقول: وقد فسر بتفسيرات:
أحدها: أن يشهد شاهدان على تفريطه، فإنّه يكره تضمّنه العين اذا لم يكن متّهماً.
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب كراهة استعمال الاجير قبل تعيين اجرته ح ١ و ٢، ج ١٣، ص ٢٤٥.
الثاني: لو لم تقم عليه بيّنة، وتوجه عليه اليمين يكره تحليفه لتضمّنه كذلك.
الثالث: لو نكل عن اليمين، وقضينا بالنكول كره تضمّنه كذلك.
الرابع: على تقدير ضمانه، وإن لم يفرط كما اذا كان صانعاً - على ما سياتي - يكره تضمّنه - حينئذٍ - مع عدم تهمته بالتقصير.
الخامس: أنّه يكره أن يشترط عليه الضمان بدون التفريط على القول بجواز الشرط.
السادس: لو أقام المستأجر شاهداً عليه بالتفريط كره له أن يحلف معه، لتضمّنه مع عدم التهمة.
السابع: لو لم يقض بالنكول كره له تضمّنه باليمين المردودة.
وأورد على الخامس: بأنّ الحقّ فساد الشرط.قلت: لا دليل على الكراهة - حينئذٍ - لو قلنا بالصحة. نعم، لا بأس به إن قلنا بعموم أدلّة التسامح لفتوى الفقيه، وعلى الأخيرين: بأن جواز الحلف أنّما هو بعد القطع لموجب الضمان، فكيف يكره التضمين مع اختصاص الكراهة بعدم الاتهام ؟
قلت: يمكن أن يقال: إنّ المأمون الذي يكره تضمّنه هو الذي له ملكة الأمانة، التي لا تنافي فعلية الحلاّف، لدواعٍ شديدة خارقةٍ للعادة.
والحاصل: أنّه إن اريد من التهمة ما يقابل هذه الملكة فعدم حصولها لا ينافي التفريط. وأخبار الباب لا تأبى بعضها عن هذا المعنى، ومستند هذا الحكم أخبار ظاهرة في ضمان المتّهم خاصّة، وحيث أن التفصيل مخالف للفتوى حملوه على كراهة التضمين.
وأقول: يمكن أن يقال: إنّ المكروه ليس هو التضمين بعد ثبوت موجب الضمان كما هو مقتضى الوجه الأوّل، والثالث، بل المكروه هو إثبات الموجب عليه.
ويدلّ عليه: خبر أبي بصير، عن أبي عبد اللّهعليهالسلام : « لا يضمن الصانع،
ولا القصار، ولا الحائل إلاّ أن يكونوا متّهمين »(١) فيخوف بالبينة، ويستحلف لعلّه يستخرج منه شيئاً.
ولا يبعد أن يقال بكراهة الجميع. وكيف كان فالأمر سهل: قوله الثالث: (أن تكون المنفعة مملوكة) وممّا يفسّر العبارة بالمملوكيّة في قبال ما لا يكون ملكاً لأحدٍ كمنافع المباحات.
والظاهر، أنّ المراد: هو المملوكيّة للمؤجر، لأنّ جواز إجارة المستأجر لا يتفرّع على المملوكيّة منفرداً بهذا المعنى، بل انقسام المملوكيّة بالمعنى الأوّل الى الانفراد والتبعيّة ممنوع. وأيضاً ذكره لإجارة غير المالك تبرّعاً لا وجه له - هنا - بناء على المعنى الأوّل.
نعم، ذكر هذا الشرط في عداد شرائط صحّة العقد يلائم الوجه الأوّل، لأنّه من شرائط الصحة الفعليّة المعبّر عنها في بعض العبائر باللزوم، لا الصحة التأهلية بمعنى القابلية بخلاف الشرائط السابقة.
وكيف كان، فاعتبار الشرط بالمعنى الأوّل من الواضحات، وكذا الثاني بالنسبة الى الصحّة الفعليّة. وأمّا التأهّليّة فاعتباره فيها مبنيّ على جريان الفضوليّ في العقود، وعدمه.
قوله: (وللمستأجر أن يؤجر)
أقول: إجارة المستأجر من غيره جائز، سواء كان المستأجر منه المؤجر، أم غيره. واحتمال المنع عن بعض الوجوه بعد إطلاق العقد الأوّل لا وجه له. وهل له تسليم العين الى غير المؤجر المستأجر منه كما عن المختلف(٢) وغاية المراد(٣) ومجمع
____________________
(١) وسائل الشيعة: ب ان الصانع اذا أفسد متاعاً ضمنه ح ١١، ج ١٣، ص ٢٧٤.
(٢) مختلف الشيعة: فيما لو سلّم العين ج ٢، ص ٤٦٢، س ٣٨.
(٣) الكتاب مخطوط غير مطبوع.
البرهان(١) والمسالك(٢) والمفاتيح(٣) والرياض(٤) ، أو لا كما عن النهاية(٥) والتحرير(٦) والقواعد(٧) وجامع المقاصد(٨) ، أو الأوّل اذا كان أمينا، والثاني اذا لم يكن كما عن ابن الجنيد(٩) ؟ أقوال.
والظاهر أنّ محلّ الكلام هو التسليم على وجه يتوقف عليه استيفاء المنفعة، إذ التسليم على غير هذا الوجه لا تأمّل في عدم جوازه بغير إذن المالك، فأنّ المستأجر الأوّل لم يكن له التسليم على غير هذا الوجه بغير إذن المالك.
فكيف يملك التسليم الى الغير حجّة المانعين أنّ التسليم تصرّف في مال الغير؟ فالمفروض أنّه بغير إذن المالك حجّة المجوّزين أنّ جواز الإجارة المقتضية للتسليم يستلزم جوازه، لأنّ الإذن في الشيء إذن في لوازمه.
وأجاب عنه المانعون: بأنّ جواز الإجارة أنّما يقتضي تسليم المنفعة، وهو لا يقتضي تسليم العين، لإمكان استيفاء المنفعة ولو باستنابة المؤجر، أو من يرضى به.
والتحقيق أن يقال: إنّ المنفعة المطلقة من حيث استيفاء المستأجر، وغيره اذا لم يمكن استيفاؤها إلاّ بإثبات اليد في الجملة أو مطلقاً، إمّا لتقوّمها به، أو لتوقّفها في الوجود عليه كانت ماهية إثبات اليد في الجملة، أو مطلقاً من توابعها.
____________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ج ١٠ ص ٣٢.
(٢) مسالك الافهام: فيما لو سلّم العين ج ١، ص ٣٢٣، س ٢.
(٣) مفاتيح الشرائع: للمستأجر ان يؤجر غيره ج ٣، ص ١٠٤.
(٤) رياض المسائل: فيما لو سلم العين ج ٢، ص ٥ س ١٩.
(٥) النهاية: فيما لو سلّم العين لغيره ص ٤٤٥.
(٦) تحرير الاحكام: في شرائط الاجارة وما يتعلق بها ج ١، ص ٢٤٥، س ١٦.
(٧) قواعد الاحكام: فيما لو سلّم العين ج ١، ص ٢٢٦، س ٢١.
(٨) جامع المقاصد: فيما لو سلّم العين ج ٧، ص ١٢٤ و ١٢٥.
(٩) مختلف الشيعة: فيما لو كان الاجير اميناً ج ٢، ص ٤٦٢، س ٣٣.
فكما أن العين يلحق بها توابعها، كذلك يلحق بالمنفعة توابعها، كما أنّ ملك المنفعة يقتضي السلطنة على تسليط الغير على استيفائها، كذلك ملك اللوازم يقتضي السلطنة على تسليط الغير عليه.
لا يقال: إنّ ملك العين يقتضي سلطنة المالك على منع غيره عن الاستيلاء عليه.
لأنّا نقول: ملك العين المسلوب عنها المنفعة بلوازمها: إمّا بإقدام المالك كما في ما نحن فيه، أولا بإقدامه - كالعين الموصى بنفسها لزيدٍ، ومنفعتها في مدة معلومة لعمرو - لا يقتضي سلطنة المالك على إثبات اليد. فكيف يقتضي السلطنة على منع الغير التي هي من وجوهها
ويمكن تقرير الدليل بوجه آخر يختصّ بإقدام المالك على ملك المنفعة بأن يقال: إنّ مقتضى المعاوضة على المنفعة المطلقة إلتزام المالك بتسليمها بإطلاقها، وبأيّ وجهٍ أراد المستأجر استيفاءها.
وبعبارة اخرى: تمليك المنفعة المطلقة متضمّن تمليك أفرادها، وللإلتزام بتسليم جميعها. فاذا أراد المستأجر استيفاء سكنى زيد، المتوقّف على إثبات يده على الدار المستأجرة كان مقتضى الإجارة وجوب تسليم الدار لاستيفاء ذلك، وعدم منع المستأجر عن ذلك.
ولكن، يمكن أن يقال: إنّ الالتزام بتسليم العين، واستحقاق المستأجر إثبات اليد عليها بأيّ وجهٍ اراده لا تقتضي السلطنة على تضييع العين، وجعلها في معرض التلف. فلا يوجب ذلك سلطنة المستأجر على تسليط غير الأمين. فالأقوى هو الوجه الأخير، ثمّ الأوّل.
ولكنّ المسألة تحتاج الى مزيد تأمّل. والاحتياط لا ينبغي تركه، فأنّه سبيل النجاة.
وهل للأجير تسليم ما آجر نفسه للعمل فيه الى غيره اذا لم يشترط عليه مباشرته - كالخياط يستأجر لخياطة الثوب، فيجوز له دفع الثوب الى غيره للخياطة بغير إذن المالك - أو لا يجوز ذلك، فيضمن العين اذا سلّمها الى غيره؟ وجهان:
من أنّه لا حقّ له على العين، بل يجب عليه تسليم العمل حيث إرادة المستأجر، وإنّما يستحقّ الاجرة اذا سلّم نفسه للعمل ولو لم يستوفه المستأجر، بل اذا منعه من العمل وإثبات اليد لم يملك. ومنع اليد على العين، وكان ضامناً لها غايته أنّه يستحق الاجرة بالتسليم، وله الزامه بقبض العمل اذا كان مطلقاً من حيث المدّة، والرجوع الى الحاكم.
ومن أنّه اذا كان المستأجر الذي يستوفي المنفعة لنفسه، ويعود نفعه اليه مسلطاً على تسليم العين الى غيره كان الأجير الذي يعمل للمالك أولى بتلك. والأقوى هو الأوّل.
وربّما يستدل في المسألة السابقة أيضاً بالأولية فيقال: الأجير الذي يستحقّ العمل اذا جاز له التسليم الى الغير كان مالك المنفعة أولى بذلك، وفيه، وفي سابقه ما لا يخفى.
وهل للحاكم إلزام المالك بالتسليم اذا رجعا اليه في المسألتين، أو له الإلزام في الاولى، دون الثانية، أو لا يلزم مطلقا ؟ وجوه.
وتنقيح الكلام: أنّ إجبار مالك العين على الأذن مناف لسلطنته، والحكم بالصبر على مالك المنفعة حتى يسلّم اليه العين ضرر.
فيمكن أن يقال: إنّ مقتضى حكومة أدلة الضرر على أدلّة السلطنة هو الاجبار على الإذن.
وأن يقال: إن الضرر يندفع بجعل الخيار وفسخ العقد، ولو شرط المؤجر عدم الخيار لأجل تعذر التسليم، وقلنا بصحة هذا الشرط - كان مقدّماً على الضرر - فلا وجه لإلزام مالك العين على الإذن.
ومن هنا ظهر: أنّه ليس للحاكم انتزاع العين من المالك، وتسليمه من المستأجر قهراً عليه، بل هذا أولى ممّا سبق.
كما لا يخفى هذا كلّه في امتناع المالك تسليم العين المستأجرة من مستأجره. وأمّا امتناع المالك من تسليم العين للأجير فالظاهر أنّه لا يوجب إجباره على التسليم.
غاية الأمر أنّه بتسليم الأجير نفسه، وانقضاء مدّة يمكن فيه العمل يستقر الاجرة عليه.
نعم، لو فرض إمكان استيفاء العمل، بعد انقضاء المدّة المفروضة - كما اذا كان أجير العمل في الذمّة - كان له إلزامه بأحد الأمرين: من تسليم العين للعمل، أو إسقاطه لما في الذمّة وتسليم الاجرة.
قوله: (وأن يشرط عليه استيفاء المنفعة بنفسه، ولو شرط ذلك فسلّم العين المستأجر الى غيره ضمنها).
أقول: الكلام - هنا - يقع في امور:
الأوّل: قد يقال: إن هذا الشرط راجع الى تنويع المنفعة، لأنّ المنفعة كلّيّ قابل للتنويع، وقد قرّر في البيع أنّ القيد - اذا كان المبيع جزئياً - راجع الى الشرط، والشرط - اذا كان المبيع كلّيّاً - راجع الى القيد.
فلو قال: بعتك عبداً، وشرطت أن يكون كاتباً راجع الى بعتك العبد الكاتب.
أقول: لا نسلّم أنّ مناط رجوع الشرط الى التنويع كون المعقود عليه كلّيّاً، بل المناط كون الشيء في نظر المتعاقدين منوّعاً، ومجرّد كون الشيء منوّعاً في الواقع لا يكفي في قصد التنويع.
ولا ريب أن مباشرة الفاعل ليست من منوّعات المنفعة عند العرف، كما أنّ كون الاستيفاء لنفسه لا يكون منوّعاً.
نعم، الفرق بينهما: أنّ اعتبار التنويع في الاستيفاء بنفسه أسهل من اعتباره في الاستيفاء لنفسه. حيث أنّ الأوّل مقسّم خارجيّ، والثاني اعتبار عقليّ محض. الثاني في صحة إجارة المستأجر لغيره لوجه العموم مع هذا الشرط.
فنقول: إن قلنا بكونه راجعاً الى التنويع فلا إشكال في أنّه بالنسبة الى سكنى
غير المستأجر الأوّل في إجارة الدار - مثلاً - فضولي، يقف على إجازة المالك، وأمّا بالنسبة الى غير ذلك فالظاهر صحّة الإجارة.
نعم، للمستأجر الثاني خيار يشبه خيار التبعّض - وسيأتي بيانه - ودعوى بطلان الإجارة - نظراً الى أنّ بعض المنفعة لا يمكن تسليمه - مدفوعة بأنّ القدرة على التسليم، مع العلم بحصول الإذن، أو رجائه على الإشكال فيه حاصلة.
وإن كان شرطاً: فإن اريد منه عدم سلطنة المستأجر على تسليطه الغير - شرعاً - على الاستيفاء، الراجع الى عدم السلطنة على النقل الى الغير فالشرط فاسد، ولا كلام فيه، لأنّه مناف لمقتضى العقد.
وإن اريد منه عدم النقل الى الغير، فإن قلنا: إنّ مقتضى أدلّة الشرط بطلان الإجارة - كما قيل في شرط عدم الفسخ في البيع باطل - فلا إشكال في وقوف الإجارة على إذن المالك، وإلاّ فالظاهر الصحة، وللمالك خيار تخلّف الشرط.
وإن اريد منه عدم استيفاء الغير - كما هو الظاهر - وكان الاشتراط عليه للحاظ قدرته على تسليط الغير على الاستيفاء كان مقتضى الشرط عدم السلطنة على ذلك.
وذلك لا يوجب عدم السلطنة على الإجارة.
نعم، إن لم يكن استيفاء المستأجر الأوّل، عن الثاني ممكناً أمكن الحكم بفساد الإجارة. حيث أنّ تملك ما لا يحصل السلطنة عليه بوجهٍ من الوجوه معاملة سفهية، إلا أن يقال:
إنّ رجاء ارتفاع المانع يخرجها عن السفهية، مع أن السلطنة على النقل ولو الى المالك حاصلة.
[ الثاني ] ثم إن سلّم العين الى المستأجر الثاني استوفى منها شيئاً من المنفعة، أو لم يستوف كان للمؤجر الأوّل خيار تخلّف الشرط، وللمستأجر الثاني إن قلنا بصحّة الإجارة خيار تعذّر التسليم ان لم يسلم اليه المنفعة بعضاً أو كلاً إن كان جاهلاً بالحال، أو كان عالماً مع البناء على التسليم بوجهٍ شرعيّ، أو مطلقاً كما هو ظاهر العقد.
ولو علم الإقدام على المعاوضة، عالماً بالحال، ملتزماً بما يرد عليه ففي ثبوت الخيار، وعدمه إشكال.
نعم، لو لم يتحقّق التسليم الى أن انقضى زمان الإجارة انفسخ العقد بالتلف قبل القبض، وكذلك الحكم بالنسبة الى أبعاض المنفعة إن قلنا بجريان قاعدة التلف قبل القبض في ابعاض البيع كما لا يبعد.
لا يقال: قضية الإجارة سلطنة المستأجر على استيفاء المنفعة، والمفروض امتناع حصول هذه السلطنة لمكان الشرط الذي شرط في الإجارة الاولى، فكيف يمكن صحة الإجارة الثانية؟
لأنّا نقول: ذلك من الأحكام المترتّبة على ملك العوضين، وليس داخلاً في مدلول العقد، ولا ريب أنّ ترتّب السلطنة أنّما هو على تقدير عدم استلزامه مزاحمة حقّ الغير، كما في الفرض الثالث في ضمان ما استوفاه المستأجر الثاني.
فنقول: إن قلنا برجوع الشرط الى التنويع فلا يخلو الحال: إمّا أن يردّ المؤجر الإجارة الثانية، أو يجيزها، فعلى الأوّل فلا إشكال في بطلانها.
ويمكن أن يقال: إن المالك يقبض الاجرة المسمّاة في الإجارة الاولى من المستأجر الأوّل، ويأخذ اجرة المثل المنفعة المستوفاة، مخيّراً في رجوعه الى أيّ المستأجرين شاء، لأنّها ملكه كما هو الفرض، وقد غصبها كلّ من المستأجرين، فتجرى أحكام الغصب حين رجوع السابق الى اللاحق، ورجوع اللاحق اليه في زيادة المثل على المسمّى إن كان مغروراً.
ويمكن أن يقال: إنّ المنفعة المغصوبة لعدم إمكان اجتماعها مع المنفعة، التي وقعت عليها الإجارة ليس لها ماليّة منجرّة.
نعم، لها ماليّة بدليّة قد استوفاها المالك بأخذ المسمّى في الأجارة الاولى. وحينئذٍ، فضمان المستأجر الثاني لما استوفاه ليس معناه إلاّ تدارك ما ورد على المستأجر الأوّل من خسارة المنفعة المستوفاة ببذل المسمّى، كما هو الشأن في تعاقب الأيادي على العين المغصوبة.
نعم، لو كانت للعين المستأجرة منفعة زاد قيمتها على ما وقع عليه العقد كانت مضمونةً على المستأجرين، سواء كانت هي المنفعة المستوفاة، أو غيرها، لأنّ تلك الزيادة لم تتدارك ببذل وانقطاع سلطنة استيفاء المالك لها بسبب الإجارة لا يوجب سلطنة الغير عليها، ولا يوجب خروج تلك المنفعة عن ملكه أيضاً - حتى لا يستحقّ - ما لم يتدارك من خسارته وإن أجاز صحّة الإجارة، ولزمت. والاجرة يملكها المستأجر الأوّل، إلاّ اذا كان بين المنافع ما يزيد اجرته على ملك المستأجر فينقل من الاجرة المسمّاة الى المؤجر الأوّل بحسب تلك الزيادة. وسيأتي لذلك، وسابقه مزيد بيان في بعض المباحث الآتية إن شاء اللّه تعالى.
وإن قلنا بالشرطية، فإن فسخ المؤجر الإجارة الاولى، لتخلّف الشرط رجع الى المستأجر الأوّل باجرة مثل ما استوفى من المنفعة حين الفسخ، ويدفع اليه الاجرة المسمّاة، كما هو قضية الفسخ، ويبطل الإجارة الثانية إن قلنا بصحّتها بالفسخ، أو يكون مالك العين مخيّراً في فسخها وإبقائها، أو يتعيّن عليه أخذ اجرة المثل وجوه، وهل تعود المنفعة إن فسخ المستأجر لتعذر التسليم بعد فسخ الإجارة الاولى الى المؤجر أو الى المستأجر الأوّليّ؟ وجهان: أقواهما الثاني.
وإن قلنا بفساد الإجارة الثانية ضمن المستأجر الثاني للمستأجر الأوّل باجرة مثل ما استوفى من المنفعة يوم الاستيفاء.
الثالث: في أنّه هل تبطل الإجارة المتضمّنة لهذا الشرط بالموت كما عن بعض(١) أولا كما في الجواهر(٢) ؟ وجهان: والأقرب هو الأول إن قلنا: إنّ الشرط راجع الى القيد وإن كان شرطاً فالثاني.
نعم، ويمكن أن يقال على الأوّل: إنّ مباشرة المستأجر للاستيفاء [ اذا ](٣) لم
____________________
(١) مسالك الافهام: في موارد بطلان الاجارة ج ١، ص ٣٢١، س ٩.
(٢) جواهر الكلام: في موارد بطلان الاجارة ج ٢٧، ص ٢٠٧.
(٣) سقطت من الأصل وأضفناها لاستقامة السياق.
تكن من مقوّمات المنفعة كان له إسقاطه، وحينئذٍ فيمكن أن يقال: إنّ بطلانها بالموت مراعى بعدم إسقاط الشرط المذكور.
وتوضيح المرام: أنّ القيود المأخوذة فيما يقع عليها العقد قد تكون من المقوّمات التي تعلّق الفرض بها ابتداءً، بحيث لا يكون الشيء على تقدير عدمه مطلوباً.
وقد تكون مطلوبيّة المقيّد منوطةً بحصوله وإمكانه، ويكون المطلق - أيضاً - له جهة مطلوبيّة، وإن كانت في حال إمكان المقيّد مقصورة في المقيّد، إلاّ أنّه بحيث لو فرض عدم إمكان المقيّد كان متعلّقاً للإرادة، كما في الأوامر بالنسبة الى الأجزاء الاختياريّة.
وهذا المقدار من المطلوبية وإن لم يوجب ورود العقد ابتداء على المطلق إلاّ أنّ القيد الذي بهذه المثابة يكون إسقاطه راجعاً الى تعميم مورد العقد، وإدخالاً لما لم يكن داخلاً فيه، مع قطع النظر عن الاسقاط فيه؛ وحينئذٍ، فاذا أسقط المؤجر قيد المباشرة كان ذلك منه تعميماً في مورد العقد، وصار ما يستوفيه غير المستأجر من مصاديقه، ولكن على تقدير صحته في نفسه إتمامه فيما نحن فيه لا يخلو عن تأمّل؛ لأنّ مورد العقد بعد اختصاصه ذاتاً بالمقيّد، فالموت متى عرض بطل، ولا يبقى مورد حتى يدخل فيه غيره.
نعم، ذلك في سائر المقامات لا يخلو عن وجهٍ يمكن أن يقال على الثاني - أيضاً - بفساد الإجارة، نظراً الى أنّ الإجارة بعد فرض امتناع استيفاء الوارث تعود سفهيّة.
وفيه: - ما عرفت سابقاً - مضافاً الى أنّ منافاة ذلك في ابتداء العقد لا يقتضي منافاته للاستدامة، مع أنّ امتناع استيفاء الوارث ممنوع، لأنّ الشرط أنّما يتضمّن عدم استيفاء من يكون استيفاءه يجبّ سلطنة المستأجر، واستيفاء الوارث بعد الموت لا يكون يجبّ سلطنة المستأجر.
نعم، يمكن أن يقال: إن الشرط راجع الى جعل المؤجر لنفسه سلطنةً على منع الغير.
قلت: رجوع الشرط الى ذلك ممنوع، ومجرّد كون الغرض من الشرط ذلك
لا يجعله مدلولاً للشرط، الذي هو الميزان للأحكام، دون الإعراض.
وهل للوارث - على تقدير الصحّة - خيار فسخ الإجارة إن قلنا بمنعه عن الاستيفاء لقاعدة الضرر، أولا؟ وجهان: أقربهما الأخير، لأنّ حقّ الوارث يمنع حق المورث، فاذا أقدم المورث على الضرر بتحمّل الشرط لم يكن فوت المنفعة بسبب ذلك الشرط ضرراً عليه. فتأمّل في جميع هذه المسائل؛ فانّ أغلبها تحتاج الى تنقيح الكلام.
الرابع: في ضمان العين على تقدير تسليمها الى الغير، وهو ممّا لا إشكال فيه لعموم (على اليد)(١) من غير سبب رافع للضمان، بل الظاهر ضمان الأخذ أيضاً.
فلو تلفت العين كان للمالك الرجوع الى كلّ واحدٍ، فإن رجع الى من لم تتلف عنده رجع هو الى صاحبه، إلاّ أن يكون مغروراً منه، وعلى فرض الغرور يرجع المغرور الى الغارّ إن رجع المالك اليه. وذلك كلّه واضح لا إشكال فيه.
لا إشكال في أنّه ليس للمستأجر تسليم العين الى غيره، وأنّه اذا سلّمها الى غيره ضمنها، لكونه تعدّياً عن القدر الذي جعل له.
كما أنّه لا إشكال في صحّة إجارتها من الغير، مع اشتراطها بمباشرته للاستيفاء عن المالك، إنّما الإشكال في صحّة الإجارة مطلقاً ومن غير شرط، وعدمها.
وقد يستدلّ للثاني: بأنّ هذا الشرط راجع الى تقييد المنفعة، لأنّها كلّيّ، والشرط المتعلّق بالكلّيّ راجع الى القيد، كما أنّ القيد المتعلّق بالجزئيّ راجع الى الشرط.
ولذلك قالوا - فيما اذا قال: بعتك العبد، وشرطت كونه كاتباً - : أنّ المبيع هو العبد الكاتب فالمنتقل الى المستأجر الأوّل من المنافع هو ما يتقوّم بمباشرته، ويكون ما يقابله من أنواع المنفعة، المتقوّمة بمباشرة غيره باقياً في ملك المؤجر.
فاذا آجر الإجارة المطلقة كان ناقلاً لماله مع مال غيره، فيقف في مال غيره على
____________________
(١) عوالي اللئالي : ح ١٠٦ ، ج ١ ، ص ٢٢٤.
إجازته، فإن أجاز وإلاّ بطل، وكان للمستأجر الخيار بالنسبة الى ما سلّم له من المنفعة.
ولذلك استثنى هذه الصورة القائلون، لعدم بطلان الإجارة بالموت، وحكموا بأنّه لا ينتقل الى الوارث، على أنّا لو سلّمنا الشرطيّة فمقتضى صحة الشرط عدم سلطنة المستأجر الأول على تسليط الغير على مباشرة الاستيفاء، وعدم صحّة العقد الصادر منه، المقتضي لسلطنة الغير على المباشرة.
ولذلك قالوا - فيمن شرط في البيع عدم الفسخ -: إنّه لا يقع منه. وقد ورد أيضاً - فيمن أعان مكاتبةً مزوّجة، وشرط عليها أن لا تفسخ نكاحها بعد الحرية - : أنّ فسخها لا يؤثّر، لأنّ المؤمنين عند شروطهم.
قلت: إمّا قضيّة التنويع فيمكن منعها، ومجرّد كون طرف العقد كلّيّاً لا يقتضي التقييد، بل ربّ شيءٍ قابل للتنويع عقلاً، ولا يكون منوّعاً عند العرف، وكون عنوان المعقود عليه هو المقيّد تابع لقصد المتعاقدين اليه، وإن كان بلفظ الشرط فيما لم يكن الشىء منوّعاً عندهما لا يتحقّق منهما القصد الى عنوان المقيّد.
وأمّا قضية الاستثناء ، فاتفاق القائلين بعدم البطلان عليه ممنوع ، بل هو محكيّ عن بعض(١) ، ومنعه بعض(٢) آخر.
وأمّا الوجه الثاني: فإن أراد من عدم صحة الإجارة عدم تأثيرها في سلطنة المستأجر الثاني على استيفاء المنفعة مباشرةً، غير المستأجر الأوّل فهو مسلّم.
وإن أمكن أن يقال: إنّ مقتضى شرط الاستيفاء عدم جواز تسليط الغير، لا عدم حصوله، لأنّ وجوب الوفاء بشرط الفعل، أو الترك لا يقتضي إلاّ وجوب ذلك، لأنّ المستفاد من الرواية السابقة، وحكم المشهور بعدم الانفساخ بفسخ من
____________________
(١) مسالك الافهام: في موارد بطلان الاجارة ج ١، ص٣٢١، س ٧، وجامع المقاصد: في موارد بطلان الإجارة ج ٧، ص ٨٤.
(٢) النهاية: في موارد بطلان الإجارة ص ٤٤١، والمهذب: في موارد بطلان الإجارة ج ١، ص ٥٠١.
شرط عليه عدم الفسخ أنّ قضية الشرط ارتفاع سلطنة المشروط عليه عن مخالفة الشرط، وأنّه اذا كانت المخالفة بعقدٍ من العقود لا يكون ذلك مؤثّراً في حصول المخالفة، على أنّا لو لم نسلّم ذلك نقول: إن سلطنة المستأجر الأوّل على تسليم العين الى الغير إنّما جاءت من اقتضاء العقد استحقاقه تسليم المنفعة بأيّ وجهٍ أراد استيفاءهما، من مباشرته أو مباشرة غيره، كما هو مقتضى الوجه الثاني من وجهي جواز تسليم المستأجر العين الى غيره.
والعقد المشروط فيه مباشرة الاستيفاء لا يقتضي استحقاق التسليم للاستيفاء بمباشرة الغير، وإن أراد من عدم صحّتها عدم تأثيرها في نقل المنفعة الى المستأجر الثاني ففيه: أنّه لا منافاة بين صحة الشرط، وصحة العقد بهذا المعنى. غاية الأمر: أنّ للمستأجر فسخ العقد إن لم يسلّم اليه العين للاستيفاء بنفسه.
نعم، إن كان استيفاء المستأجر الأوّل المنفعة عن المستأجر غير ممكن أمكن أن يقال بفساد الإجارة، لأنّ تمليك منفعةٍ لا يمكن استيفاؤها بوجه معاملة سفهيّة، فتأمّل.
مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ القدرة والتسليم مع هذا الشرط غير حاصلة للمستأجر الأوّل. وفيه: أن رجاء إذن المؤجر كاف في حصول القدرة، فتأمّل.
فتلخّص ممّا ذكرنا: أنّه لا مانع من صحة الإجارة اذا كانت مباشرة المستأجر الأول للاستيفاء عن المستأجر الثاني ممكناً. غاية الأمر: أنّ للمستأجر الثاني فسخ العقد إن طلب المباشرة، ولم يسلّم اليه العين.
وأمّا مع عدم إمكان استيفاء الأوّل المنفعة عن الثاني فالصحة غير خاليةٍ عن الإشكال وإن كان لها وجه أيضاً.
ثم إنّه لا إشكال - بناء على عدم رجوع الشرط الى القيد - في أنّه ليس للمؤجر مطالبة المستأجر الأوّل، ولا الثاني باجرة المثل إن سلّم العين الى غير من شرط مباشرته للاستيفاء.
وإن قلنا: بأنّ الإجارة الثانية باطلة، وذلك واضح إنّما الإشكال في أنّه بناء
على التنويع له الرجوع باجرة المثل الى أحدهما، أو ليس له.
فيمكن أن يقال: إنّ المستأجر الأوّل غصب ما لم يكن له من المنفعة، وسلّمها الى غيرهما، فهي في ضمانهما، ويجب على كلّ من رجع اليه المالك أن يخرج عن عهدتها.
وأمّا المنفعة التي ملكها المستأجر الأوّل وقد فوّتها بنفسه فلا يرجع الى المؤجر باجرة المسمّى، لأنّ إتلاف المشتري قبل القبض ليس من مال البائع، وإن كان إتلاف البائع للمبيع قبل القبض من ماله.
ويمكن أن يقال: إنّ غصب المستأجر الأوّل لا يوجب ضمانه لاجرة المثل، لأنّ المنفعة المغصوبة لمّا لم يكن اجتماعها مع المنفعة، التي ملكها بالإجارة لم يكن لها ماليّة خارجيّة الأبد، لا عمّا ملكها المستأجر الأوّل، والمفروض أنّ المؤجر استوفى ماليّة تلك المنفعة، التي ملكها المستأجر باجرة المسمّى، فليس للمنفعة المغصوبة ماليّة غير مستوفاة توجب الغصب خروج الغاصب عنها.
ومن هنا ظهر: أنّه لا يضمن المستأجر الثاني - أيضاً - للمؤجر، إذ الفرض أنّه استوفى الماليّة باجرة المسمّى، التي أخذها من المستأجر، فليس لهذا المال ماليّة غير متدارك لمالكه حتى يلزم على أحدٍ تداركه له.
نعم، للمستأجر الأوّل الرجوع الى الثاني باجرة المثل، لأنّ مقتضى ضمان المستأجر الثاني خروجه عن عهدة المال المغصوب ولو بأداء بدله الى من خرج عنه عهدته، كما هو الشأن في تعاقب الأيادي على العين المغصوبة.
نعم، إن كان بين المنفعة المغصوبة، والمنقولة بالعقد تفاوت في القيمة رجع المالك الى من شاء منهما بتلك الزيادة. ثمّ هو إن كان غير من استقرّ التلف عنده رجع اليه بذلك.
ثمّ إنّ مقتضى ما ذكرنا من عدم رجوع الشرط الى القيد أن لا ينفسخ العقد كموت المستأجر، بل تنتقل المنفعة بالإرث.
وهل للوارث الاستيفاء بدون إذن المؤجر أو وارثه، أو لا؟ وجهان:
من أنّ قضية الشرط راجعة الى عدم تسليم العين الى غير المستأجر، وذلك لا يشمل استيلاء الوارث بعد الموت، لأنّ ذلك لا يدخل تحت اختيار المستأجر.
ومن أنّ الغرض منع عدم سلطنة غير المستأجر على العين، وإبقاء سلطنة المؤجر على منع الغير عن الاستيلاء عليها، بل لعلّه هو الشرط حقيقةً، ومحصله أن يكون للمالك حقّ منع الغير عن الاستيلاء.
ويمكن أن يقال: إنّ الشرط هو مباشرة المستأجر لاستيفاء ما يقع استيفاؤه، وفائدته سلطنة المؤجر على منع الغير عن الاستيفاء.
الاّ أن يقال: إن ذلك يتفاوت بحسب المقامات، فقد يتعلّق الغرض بكون المستأجر مباشراً من حيث خصوصيّته في مباشرته، وقد يتعلّق لعدم مباشرة الغير.
هذا كلّه على تقدير عدم رجوع الشرط الى القيد، وأمّا إن رجع اليه فالظاهر هو البطلان بالموت.
ويمكن أن يقال: إنّ قيد المباشرة وإن كان منوّعاً إلاّ أنّه ليس من مقوّمات المنفعة، التي يعدّ فاقدها مبايناً لواجدها.
وبعبارة اخرى: قد تكون مطلوبيّة المقيد، وعدم مطلوبية المطلق بدون القيد، لأجل تقوّم الغرض بالمقيد، بحيث لو فقد القيد كان المطلق مبايناً للمقصود، وقد يكون ذلك لأجل خصوصيّة في المقيّد، ويكون تعيّنه لأجل عدم فوات ملك الخصوصيّة، بل لو فرض عدم القيد كان للمطلق مرتبة من المطلوبيّة. وعدم المطلوبيّة الفعليّة لأجل مراعاة حصول تلك الخصوصيّة. وأشبه شيء بذلك هو الواجب بالنسبة للأجزاء الاختياريّة.
وحينئذٍ نقول: وإن كان مورد العقد هو المقيّد، وما لم يسقط القيد لا يكون المملوك به إلاّ المقيّد أنّ هذا المقيّد يعدّ من مقولة الشرط، بحيث لا يوجب إسقاطه عن الذمّة زوال المطلق، وتكون فائدة سقوطه توسّعه فيما تعلّق العقد به، وإدخالاً لما لم يكن داخلاً فيه، فيكون بطلان الإجارة مراعى بعدم إسقاط المؤجر قيد المباشرة.
وفي صحّة ذلك من غير إرجاعه الى تبديل المملوك بالعقد بغيره تأمّل. ومع تسليم جريانه في محلّ البحث لا يخلو عن إشكال، حيث أنّ انفساخ العقد بالنسبة الى المقيّد لا ينفكّ عن الموت، فلا يبقى مورد حتى يوسّع فيه بإسقاط القيد، فتأمّل.
وهو للوارث - إن قلنا بصحة العقد، وممنوعيته عن التصرف بغير إذن المؤجر - أن يفسخ، لأنّ لزوم العقد ضرر عليه، أولا، لأنّ حقّ الوارث يتبع حقّ المورث، فإقدامه على ذلك بمنزلة إقدام الوارث؟
وبعبارة اخرى: الوارث قائم مقام المورث، فإقدام المورث إقدامه، وجهان: ولا يخلو الأوّل عن قوّة، لأنّ التنزيل في الاقدام لا يكون مؤثّراً في رفع الضرر، مضافاً الى أنّ إقدام المورث على سلطنة المؤجر على منع الوارث لا يستلزم الإقدام على فوات المنفعة عليه، بل لعلّ الشرط على هذا الوجه بجعل المعاملة سفيهةً لا يقدم عليه العقلاء، ولعلّ مرجع شرط مباشرة الاستيفاء الى سلطنة المؤجر على منع الوارث بفسخ العقد، أو سلطنة المؤجر على منع الوارث، وسلطنته على الفسخ إن منعه.
ويمكن أن يقال: بفوات المنفعة لعدم تسليم العين ينفسخ العقد، لكون التلف قبل القبض، فلا ضرر على الوارث. وفيه: أنّ الصبر الى حصول الفوت، وانقطاع سلطنته عن المنفعة، وبدله ضرر - أيضاً - عليه.
هذا غاية ما اقتضاه النظر عاجلاً؛ ولكنّه يحتاج الى مزيد تأمّلٍ، واللّه الهادي.
ثم إنّ بعض الشرّاح(١) - نور اللّه ضريحهم - زاد بعد قول المصنف: (بنفسه) قيد (لنفسه)، وحكم بمقتضاه بفساد الإجارة الثانية.
قلت: فساد الإجارة على تقدير صحة هذا الشرط يظهر وجهه ما مرّ، إلاّ أنّ في صحته تأمّلاً، لأنّ إرجاعه الى القيد لا يمكن، لأنّ جهة الانتفاع لا تكون مقسماً للمنفعة، وكونه شرطاً - كما هو الظاهر - يرجع الى شرط عدم نقل المنفعة الى الغير. ولو بشرط مباشرة المستأجر الأوّل للاستيفاء، فيكون كشرط عدم البيع في البيع،
____________________
(١) جواهر الكلام: فيما لو شرط استيفاء المنفعة بنفسه ج ٢٧، ص ٢٦٠.
وهو راجع الى عدم بعض أنحاء السلطنة التي يقتضيها العقد، وصحة هذا الشرط في غاية الإشكال وإن صحّحنا شرط البيع في البيع، لأن ذلك لا يرجع الى منع السلطنة، بل هو لازم له.
والحاصل: أنّه فرق بين شرط بعض أنحاء السلطنة، الذي يلزمه منع الغير، وشرط عدم بعض أنحائه، حيث أنّ منافاة الثاني لمقتضى العقد ظاهر بخلاف الأوّل فانّه بنفسه لا يكون منافياً، وأنّما المنافاة من حيث لازمه.
قوله: (الرابع: أن تكون المنفعة معلومةً).
أقول: لا إشكال في اعتبار المعلوميّة في صحة العقد، وأنّه بدونها لغو لا يترتب عليه الأثر.
ويدلّ عليه بعد الإجماع أنّه غرر، فلا يصح العقد على معيّن مجهول، وربّما يخرج بهذا الشرط المبهم في ذاته كأحد المنافع، وفيه إشكال، فأنّ ما وقع عليه العقد لا يكون مجهولاً، لأن الفرد المردّد كالكلّيّ أمر معلوم في ذاته، غاية الأمر: أنّ تحقّقه في الخارج قابل لمحالّ كثيرة كالكلّيّ.
ومن هنا ظهر: أنّ الحكم بفساد العقد عليه، لكونه غرراً لا وجه له. نعم، لو فرض الجهل بمصاديقه كان غرراً، ولكنّه خارج عن محلّ الكلام.
وربّما يستدلّ: بأنّ الفرد المنتشر مفهوم، منتزع من امور خارجيّةٍ، ليس له إلاّ الوجود الاعتباريّ، وليس هو كالكلّيّ الذي يتّصف بالوجود الخارجيّ بوجود أفراده، فلا يكون متعلّقاً للملك.
ولقائل أن يقول: إنّ وجود منشأ انتزاعه في الخارج كاف في تعلّق الملك به، وتسليمه بتسليم منشأ انتزاعه، فتأمل. فإن ثبت إجماع على الفساد وإلاّ فلا يخلو عن إشكال.
ثمّ إنّ متعلق العقد إمّا بعض المنافع، وإمّا جميعها، فإن كان بعض المنافع فهو - أيضاً - قد يكون على وجه الإهمال كآجرتك لخياطة هذا الثوب، وقد يكون على وجه العموم كآجرتك العبد للخياطة في هذا الشهر.
وإن كان جميع المنافع فهو - أيضاً - قد يراد به جنس المنفعة بجميع وجوداته، وقد يراد عناوين المنافع بأنفسها. فهذه صور أربع:
أمّا الأوّل: فيعتبر فيه تعيين الجنس بالنسبة الى ما تخلف به المالية والأغراض من الخصوصيات اللاحقة له كالروميّة والفارسية في المثال المفروض، لأنّ المستأجر لا يعلم ما يحصل له من الأشخاص، مع عدم التعيين.
ويعتبر في الثاني العلم بما يمكن حصوله من الأنواع المظاهرة، بعضاً أو كلاً من العين المستأجرة. وأمّا النوع النادر فلا يعتبر العلم. وسيأتي تنقيحه.
ويعتبر في الثالث العلم بعناوين تلك المنافع، الأفراد الظاهرة منها، والعلم بما يحصل من تلك المنافع في مدّة الإجارة بحسب ظاهر مقتضى الحال.
وأمّا العلم بالأفراد النادرة وحصولها فالظاهر أنه لا يعتبر في صحة الإجارة، وأنّ مثلها مثل توابع المبيع وبعض أجزائه كأساس الدار، والأخشاب الداخلة في السقف، والجدار في أنّه لا يجعل الجهل بها معاملةً غرريّة. نعم، ربّما يوجب الجهل بها خيار الغبن.
والحاصل: أن مناط الغرر هو الجهل على وجهٍ تعدّ المعاملة معه غرراً، ومناط الغبن هو تفاوت المسمّى، واجرة المثل بما يتغابن به الناس، مع الجهل عند المعاملة بذلك، ولا ملازمة بينهما من الجانبين.
وممّا يتفرّع على هذا النوع من الإجارة أنّ فوات بعض المنافع، أو حدوثها في أثناء المدّة لا يؤثّر في بطلان العقد بالنسبة الى تلك المنفعة على الأوّل، وعدم شموله له على الثاني، لأنّ متعلّق العقد هو جنس المنفعة بجميع وجوداتها. فالمتلبّس بهذا العنوان حين تلبّسه به كان داخلاً في العقد، ومقصود للمتعاقدين، وحين عدم التلبّس كان خارجاً، وغير مقصود في أوّل الأمر.
والحاصل: أن فوات المنفعة لا يستلزم فوات متعلّق الإجارة، وكذلك حدوثها لا يلازم خروج الحادث عن مورد العقد.
وأمّا الرابع: فيعتبر فيه العلم بجميع تلك العناوين، إذ مع الجهل يصدق على المعاملة أنّها غررية، ويتفرّع على ذلك بطلان الإجارة بالنسبة الى ما يقدّر استيفاؤه في أثناء المدّة من المنافع، ويردّ من الاجرة المسمّاة بالنسبة، وأن يكون ما يتجدّد من المنافع في أثناء المدّة خارجاً عن العقد.
ومن هنا ظهر: أنّ إطلاق الحكم بوجوب العلم بجميع المنافع اذا كان مقصوده الذي يتعذّر أو يتعسّر غالباً لا وجه له.
قوله: (إمّا بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم، وإمّا بتقدير المدّة كسكنى الدار).
أقول: الجهالة بكمية المنفعة ترتفع تارةً بتقديرها، واخرى بتقدير مدّتها، ولا يطرد كلّ في مورد الآخر. فقد يجتمعان كالخياطة، فأنّها تتقدّر بنفسها كخياطة هذا الثوب، وبالزمان كخياطة شهر. وقد لا يكون إلاّ الثاني كسكنى الدار، وقد لا يكون إلاّ الأوّل كضراب الفحل.
قوله: (ولو قدّر بالمدّة والعمل مثل أن يستأجر ليخيط هذا الثوب في هذا اليوم قيل يبطل، لأنّ استيفاء العمل في المدّة قد لا يتّفق غالباً، وفيه تردّد).
أقول: اعتبار المدّة اذا كان العمل مقدّراً بنفسه يتصوّر على وجهين:
أحدهما: أن يكون قيداً أو شرطاً راجعاً الى استيفاء العمل في الأثناء.
والثاني: أن يراد منه تطبيق العمل على الزمان، بحيث لا يقع شيء من العمل في غير ذلك الزمان، ولا يخلو شيء من ذلك الزمان عن ذلك العمل.
ولعلّ مراد المصنف هو الثاني، وإن ادّعى ظهور العبارة تارةً في الأوّل، واخرى أنّها جهالة فأنّ التعليل لا ينطبق على الأوّل، ضرورة أنّ الإجارة على هذا الوجه شائع واقع، وكذلك العبارة لا توافقه، لأنّ المدّة على الوجه الأوّل لا تكون مقدّرةً لكمّية العمل، بل وكذلك الثاني، إلاّ أنّ الثاني أشبه شأناً بالكميّة من الأوّل.
وكيف كان، فلا إشكال في أنّه اذا علم بقدرة الأجير على ذلك بحيث مع ملاحظة الطوارئ العادية صحّ العقد، كما أنّه لا إشكال في البطلان مع العلم بالعدم.
وأمّا مع الجهل به فالظاهر أنّه - أيضاً - باطل للغرر، ولا فرق في ذلك بين الصورتين، لا بين أن تكون المدّة مأخوذةً على وجه الشرطية، أو قيداً للعمل.
ثمّ إنّه حيث حكمنا بصحة الإجارة يتخيّر المستأجر بين الفسخ والامضاء، فإن اختار الفسخ، ولم يعمل شيئاً فلا إشكال، وإن عمل استحق اجرة مثل ما عمل على إشكال في ذلك، على تقدير كون المدّة مأخوذةً على وجه القيد به. فانه قد يقال مع انقضاء المدّة: لا تبرأ ذمّة الأجير عن العمل الخاص، فللمستأجر أن يطالبه باجرة مثل العمل، وأن يفسخ العقد فيردّ المسمّى منه، ولا يجب عليه - على التقديرين - باجرة بالنسبة الى ما عمله الأجير، لأنّه غير ما وقع عليه العقد، ولم يكن مأموراً به أيضاً.
نعم، إن قبله عوض ما في الذمّة كان له ذلك، ودعوى أنّ فائدة مثل هذا القيد لكونه غير مقوّم هو فائدة الشرط مدفوعة: بأنّ ذلك أنّما يقتضي أن يكون للمستأجر إسقاط القيد، وقبول الفاقد له، لا أنّه مع تعذّر القيد ملزم - على تقدير إمضائه للعقد - بقبول الفاقد.
والحاصل: أنّ تعذّر القيد لا يوجب انقلاب ما في ذمّة الأجير الى المطلق، مقروناً بثبوت الخيار له.
ثم إنّه إن كان لعمل الأجير أثر حاصل في مال المستأجر - كالصفة الحادثة في الثوب من الخياطة - فهل للأجير إلزامه بقيمة ذلك أو لا يلتزم بذلك، بل له منع الأجير عن التصرف في ماله اذا أراد إزالة تلك الصفة؟ وجهان: والأقوى - عاجلاً - هو الأخير، إلاّ أنّه يحتاج الى تأمّلٍ وتنقيح. فانّ الظاهر أنّ هذه شبهة بدويّة، تمهيد مقال لتوضيح حال.
إعلم: أنّ العمل إن قدّر بغير المدّة فقد تعتبر فيه المباشرة، وقد لا تعتبر، وعلى التقديرين: إمّا أن تعتبر فيه أن تكون من زمان معيّنٍ الى أن يتمّ العمل من غير توان، أو لا يعتبر فيه ذلك.
وإن قدّر بالمدّة فقد يقدّر بمدّة كلّيّة كشهرٍ، أو جزئيّة كهذا الشهر، وعلى التقديرين، فقد تعتبر المباشرة فيه، أو لا تعتبر، فهذه ثمانية صور:
الاولى: أن تعتبر المباشرة، وأن تكون من زمان معيّنٍ.
الثانية: أن يعتبر الأوّل دون الثاني.
الثالثة: أن يعتبر الثاني فقط.
الرابعة: أن لا يعتبر القيدان.
الخامسة: أن يقدّر بمدّة كلّيّةٍ مع المباشرة.
السادسة: أن يقدّر بمدّة كلّيّةٍ بدون المباشرة
السابعة: أن يقدّر بمدّة جزئيةٍ مع المباشرة
الثامنة: أن يقدّر بالمدّة الجزئيّة بلا مباشرة.
اذا عرفت هذا فاعلم: أنّ الأجير على الوجه السابع يسمّى أجيراً خاصّاً، وتلحق به الصورة الاولى.
وأمّا اعتبار كون العمل في مدّة تزيد عنه بذلك لا يكون تقديراً للعمل بالمدّة، بل هو تخصيص العمل بوجهٍ من وجوهه.
ثمّ إنّ اعتبار المدّة على هذا الوجه إن كان مع قيد المباشرة فقد يلحقه حكم الأجير الخاصّ بالنسبة الى بعض الأقسام كالإجارة المستوعبة لذلك الزمان، مع قيد المباشرة.
فعلم مما ذكرنا: أنّ مناط الأجير الخاصّ ليس مجرّد كون العمل الذي وقّع عليه عملاً خارجياً، بل المناط كون الإجارة بحيث تستوعب زماناً خاصّاً بالنسبة الى عمل شخص خاصّ، فافهم واغتنم.
قوله: (والأجير الخاصّ الذي يستأجر مدّةً معيّنةً لا يجوز له العمل لغير المستأجر إلاّ بإذنه).
أقول: قد عرفت أنّ الأجير الخاصّ هو يستأجر مدةً معيّنةً مع قيد المباشرة، ولعلّ عدم اعتبار المصنّف ذلك لوضوحه، أو لأنّ الإجارة مع كون الزمان المعيّن مقدّراً - اذا لم يعتبر فيها قيد المباشرة - ترجع الى كون الأجير هو كلّيّ، عامل ذلك العمل، والمؤجر - حينئذٍ - لا يكون أجيراً.
والحاصل: أنّ الأجير هو الذي ينقل عمل نفسه، فاختصاصه واشتراكه إنّما هو بملاحظة التقدير بالمدّة.
وكيف كان، فلا إشكال في أن الأجير للعمل المجرّد عن المباشرة يلحقه حكم الأجير المشترك، والأمر في ذلك سهل.
ثمّ إنّ الأجير على هذا الوجه: إما أن يكون أجيراً على عملٍ خاصّ، أو ينقل سائر منافعه.
أمّا الثاني فلا إشكال في أنّه لا يجوز له العمل لغير المستأجر، لأنّه يصرف في ملك الغير، وقصده كون العمل لغير المستأجر لا يكون منوّعاً حتى لا يكون العمل على هذا الوجه داخلاً في الإجارة، مع أنّ ذلك إن أثّر في التنويع كان النوع الحاصل منه داخلاً في الإجارة، إذ الغرض تمليكه سائر منافعه، فتأمّل.
نعم، إن كان شاهد حال، أو فحوى كلام فلا بأس.
وأمّا الأول: فعدّ جواز عمله مطلقاً، بمعنى حرمته مبنيّ على مسألة الضدّ.
ثمّ إنّ الكلام في الأول، تارةً في أن يعمل لغير المستأجر العمل المستأجر عليه، واخرى في أن يعمل غيره. ويظهر من الكلام في الأول حكم من ملك سائر منافعه.
فنقول: إنّ عمله لغير المستأجر عليه إمّا بإجارة، أو جعالةٍ، أو تبرّعٍ، والكلام في الأوّل يغني عن الأخيرين إلاّ في بعض ما نشير اليه إن شاء اللّه تعالى.
فنقول: إنّ المستأجر إمّا أن يجيز الإجارة الثانية، أو يردّها. فإن أجازها ملك الاجرة المسمّاة، ويرجع الى المستأجر الثاني إن لم يجز القبض وكانت الاجرة في الذمّة.
وإن أجازها، وكانت في الذمّة رجع الى الأجير خاصّةً، وكذا اذا كانت عيناً. وإن لم يجز، وكانت عيناً فله الرجوع الى الأجير إن قبضه، والى المستأجر وإن كانت الاجرة عند الأجير لاقتضاء المعاوضة تسليم الاجرة.
ثمّ إنّ في صحّة الإجارة - بناء على كونها ناقلةً - إشكالاً، فأنّ العمل التالف لا يقبل الملك، فكيف تؤثّر فيه الإجازة وأيضاً كيف لا يحكم على الإجارة الاولى بالانفساخ لتلف المنفعة قبل القبض، إلاّ أن يلتزم القائل بالنقل بصحة العقد، على تقدير تلف أحد العوضين، ويكون معناها وجوب ترتيب أحكام صحة ذلك ومع ذلك لا يندفع الإشكال الثاني وهو عدم الحكم بانفساخ العقد الأوّل، لأنّ الإجازة لا تؤثّر في القبض قبل وقوعها، بناء على كونها ناقلةً، بل في صحة أصل الإجازة على جميع التقادير إشكال، من حيث أنّه يعتبر في تأثيرها عدم سبق ناقلٍ لملك المجيز الى غيره، فلا يبقى مورد للإجازة إن قلنا: إنّ التلف قبل القبض، ولو بإتلاف البائع يوجب انفساخ العقد الأوّل.
وإن ردّها فهل يحكم بصحة الإجارة الاولى، إمّا لأنّ استيفاء الغير للمنفعة لا يعدّ تلفاً، أو لأنّ إتلاف البائع خارج عن حكم التلف قبل القبض، وأنّه مخيّر بين الرجوع الى الأجير في اجرة مثل المنفعة لإتلافه إيّاها، والى المستأجر الثاني لاستيفائه إيّاها، أو يحكم بالانفساخ خاصّةً للتلف قبل القبض، أو يكون مخيّراً بين استرداد الثمن واجرة المثل؟ وجوه: أقواها الأوسط، ثم الأخير.
وتوضيح ذلك: أنّ مقتضى قاعدة التلف قبل القبض - بناء على شمولها لما نحن فيه - انفساخ المعاملة قبل التلف، بناء على اقتضائها تقدير الملك قبل التلف آناً ما، أو بالتلف، ومعه لا يبقى مورد لقاعدة الإتلاف.
أمّا على الأوّل فظاهر، حيث أنّ التلف لا يردّ على ملك المستأجر.
وأمّا على الثاني فلأنّ الضمان، ومعناه استقرار بدل التالف في الذمّة مرجعه الى حصول البدل في محلّ المبدل، والمفروض أنّ التلف مع إمضائه الانفساخ يزيل محلّ المبدل.
والحاصل: أنّ مقتضى القاعدة بين ترتيب زوال ملك المشتري عن المبيع، واستقرار القيمة له في ذمّة البائع على التلف في زمان واحدٍ، وحيث أنّ الثاني مترتّب على عدم الأوّل، لكونه منه بمنزلة الموضوع من المحمول لم يبق مجال لتأثير التلف في الثاني، فتأمّل.
نعم، لو قلنا: إنّ قضيّة قاعدة التلف هو ضمان المبيع بالثمن دون الإنفساخ كان الوجه تخيّر المستأجر بين استرداد الثمن، واجرة المثل، لأنّ تزاحم السببين، مع اشتراكهما في أصل الضمان في تعيين البدل، ومع التساقط في جهة التعيين يكون ملك المشتري أحد الأمرين على جهة البدليّة.
كما أنّ المالك للعين، التي تعاقبت الأيدي عليها مالك في ذمّة كلّ منهم البدل على جهة البدليّة.
كما أنّ الوجه، مع قطع النظر عن ورود سبب الانفساخ على سبب الضمان أنّه عند التعارض يبطل كلّ واحدٍ منهما، كما هو شأن المتزاحمين كبيع الوكيل والموكّل في زمان واحدٍ إلاّ أن يقال:
إنّ سببيّة التلف قبل القبض للانفساخ، وكذلك سببيّة الإتلاف للضمان غير معلومةٍ في محلّ الفرض، فالقاعدتان متعارضتان، وليس توارد التلف والإتلاف من قبيل تزاحم السببين، وحيث لا ترجيح لإحدى القاعدتين على الاخرى كان الوجه التخيّر في العمل.
وفيه: مع أنّ ظاهرهما السببيّة، ومجرّد التزاحم في المورد لا يوجب طرح هذا الظاهر، إذ توارد السببين المتخالفين في الأثر غير عزيز أنّ المتعارضين اذا كان بينهما عموم من وجهٍ يتساقطان، فينبغي الرجوع فيما نحن فيه الى استصحاب بقاء العقد، وملك الأجير الاجرة المسمّى أن نسلّم عدم الترجيح لأحدها على الآخر.
نعم، إلزام المستأجر بقبول اجرة المثل عليه لاقتضاء العقد تسليم نفس المنفعة، وإلزامه بالفسخ اذا طالب اجرة المثل - أيضاً - ضرر عليه، لأنّ بعض مراتب المنفعة يتدارك ببدله العرفي، فيجب الحكم بكونه مخيراً [ بين ](١) الفسخ وإلزام الأجير باجرة المثل. مع أنّه يمكن التمسّك للضمان بقاعدة الإتلاف، لأنّ الاستصحاب محقّق لموضوعها، والسقوط إنّما كان لمعارضتها بما يوجب زوال الموضوع، فتأمّل.
قوله: (اذا سلّم العين المستأجرة، ومضت مدّة يمكن فيها استيفاء المنفعة لزمته الاجرة - وفيه تفصيل - وكذا لو استأجرها وتسلّمها، ومضت المدّة ولم يسكن).
أقول: لا إشكال في أنّ الاجرة تملك بنفس العقد، ويجب أداؤها بتسليم المنفعة المتحقّقة بتسليم العين في غير إجارة الحرّ، وبتسليم العمل فيها.
ولكنّه يعتبر في لزوم الاجرة - بمعنى عدم سلطنة المالك - ارتجاعها بالخيار، وعدم رجوعها اليه بالانفساخ بمقتضى ضمام المعاوضة - التي يأتي الكلام فيها إن شاء اللّه تعالى - تمام التخلية بين المستأجر، وتمام العمل، وتسليم تمام المنفعة، ولا يتحقّق شيء منها بدون انقضاء مدّة يمكن فيها استيفاء المنفعة.
ثمّ إنّ متعلّق الإجارة إما عين شخصيّة، أو كلّيّة. وعلى الأول، فتقدير المنفعة
____________________
(١) اضفناها لإستقامة السياق لكون العبارة في المخطوط مضطربة.
إمّا بالزمان، أو بغيره.
ظاهر قول المصنف: (اذا سلّم العين المستأجرة، هي العين الشخصيّة فلا يشمل الكلّي، ومقتضى تعرّضه للمقدّر بالمدّة بعد التفصيل أنّ مراده صورة تقدير العمل بغير المدّة، وحينئذٍ، محمل التفصيل على الفرق بين الكليّ فلا تستقرّ فيه، وغيره فتستقرّ، أو على الفرق بين المقدّر بالزمان فتستقرّ، وغيره فلا تستقرّ لا وجه له).
ولقد أفاد سيّدنا الاستاذ - جعلني اللّه فداه - في تفسير العبارة ما حاصله: أنّ تسليم العين الشخصيّة، التي تعلّق بها الإجارة قد يكون تعيّنيّاً للمنفعة الكلّيّة في منفعة العين في الزمان المتّصل بالتسليم، فيكون تسلّم المستأجر قبولاً لتعيين ما ملكه من الكلّيّ في منفعة الزمان الشخصيّ المتّصل بالتسليم.
وقد يكون المراد به: التعيين في ذلك بالاستيفاء، فيكون تسلّم المستأجر قبولاً لتعيين الكلّيّ بالاستيفاء، فاذا لم يتحقّق الاستيفاء لم يتعيّن الكلّيّ في منفعة ذلك الزمان.
غاية الأمر: أنّ منفعة ذلك الزمان مضمونة على المستأجر، فالإجارة على العمل باقية.
وحاصل الفرق بين الصورتين: أنّ التسليم في الصورة الاولى معيّن للمنفعة الكلّيّة في منفعة الزمان المتصل به، فاذا لم يستوفها فقد فوّت على نفسه ماله.
وأمّا على الصورة الثانية، فالتعيّن متعلّق على الاستيفاء، فما لم يستوف لم يتعين. وحينئذٍ، فإن قلنا: إنّ هذا المقدار من التسليم كاف في لزوم الاجرة لزمت الاجرة، وضمن منفعة ذلك الزمان، واستحقّ الاستيفاء من الأزمنة المتأخّرة إن بقيت العين، وإن تلف فلا شيء. وإن قلنا: أنّه لا يكفي ذلك في اللزوم، إمّا لأنّ التسليم على هذا الوجه راجع الى التوكيل في التعيين، فما لم يعمل بالوكيل لم تحصل التخلية من قبل المؤجر، أو لأنّ مجرّد التخلية ما لم يحصل القبض لا يكفي في رفع الضمان، ويد المستأجر على المنفعة في مثل الفرض لا تكون قبضاً للكلّيّ إلاّ عند الاستيفاء، فالاجرة غير لازمةٍ، ومنفعة ذلك الزمان مضمون على المستأجر، فإن تلفت العين
كان ضمان المعاوضة على المؤجر، [ وعلى ](١) المستأجر الاجرة المسمّاة، ويرجع المؤجر اليه باجرة ما فات تحت يده من المنافع. وحينئذٍ نقول:
مراد المصنّف من التفصيل: أنّه إن كان التسليم تعيّنيّاً لزمت الاجرة، وإن كان تعيّنيّاً له بالاستيفاء لم تلزم، لعدم تحقق القبض الذي هو مناط لزوم الاجرة، إمّا لأنّ التخلية غير حاصلةٍ، أو لأنّ التسليم معتبر، وهو غير حاصل.
ولكنّ الإنصاف: أنّ عدم صدق التخليلة لا وجه له، ورجوع ذلك الى التوكيل ممنوع، بل ذلك أمر بالاستيفاء، وتعيين الكلّيّ في المستوفاة، فتأمّل، فأنّه لا يخلو عن دقّةٍ، وسيأتي - أيضاً - أنّ المسقط لضمان المعاوضة هو التخلية.
وكيف كان، مجمل كلام المصنف على هذا بالغ أقصى غاية الجودة، ونهاية الوجاهة.
ثمّ إنّك قد عرفت أنّ الإجارة باعتبار كلّيّة متعلّقها، وجزئيته، وباعتبار تقدير العمل بالمدّة، وبغيرها تنقسم الى أقسام ثلاثةٍ:
فنقول: اذا كان متعلّق الإجارة جزئيّاً، وكانت المنفعة مقدّرةً بالمدّة وسلّم المؤجر العين من المستأجر، ومضت المدّة لزمت الاجرة، وخرج المؤجر عن ضمان المعاوضة.
أما اذا تسلّم المستأجر فظاهر، لأنّه القبض حاصل حقيقةً.
ودعوى أنه اذا لم يستوف المستأجر لم يتحقّق القبض حقيقةً، لأن المنفعة لا وجود لها إلاّ بالاستيفاء، مدفوعة بأنّ فوائد الأعيان في كلّ زمان لها وجود اعتباري بالنسبة الى ذلك الزمان، وتدخل (تحت اليد) تتبع العين، على أنّا لو سلّمنا عدم القبض فنقول:
إنّ تفويت المستأجر والمشتري للمنفعة والمبيع بمنزلة القبض في سقوط ضمان المعاوضة.
____________________
(١) أضفناها لاستقامة السياق.
ومن ذلك ظهر: أنّه مع عدم التسلّم - أيضاً - يلزم الاجرة، لأنّ فوت المنفعة مستند الى المستأجر، مع أنّه يكفي في سقوط ضمان المعاوضة التخلية بين المنفعة والمستأجر، سواء منعنا دخولها (تحت اليد) بغير الاستيفاء، أم لا، وإن كان جزئيّاً، وكان تقدير المنفعة بغير المدّة.
فإن كان التسليم تعيّنيّاً للمنفعة في منفعة العين في الزمان المتصل به، وتسلّم المستأجر فلا إشكال في لزوم الاجرة، وانفكاك العين عن الإجارة، بمضيّ مدة يمكن فيها الاستيفاء، سواءً استوفى المستأجر أم لا، إذ بالتعيين، والقبول منهما خروج المنفعة عن الكلّيّة، وتبيّن فيما عيّنّاه فيه، وحصل القبض الموجب بسقوط الضمان، وانفكاك العين، واذا امتنع من التسلّم فيعرف الكلام فيما سيأتي، إن شاء اللّه تعالى.
وإن كان التعيين المذكور معلّقاً على الاستيفاء، وتسلّم المستأجر، ولم يستوف المنفعة فقد عرفت الكلام فيه ممّا سبق مستوفى.
وإن كان متعلّق الإجارة كلّيّاً، فإن عيّنّاه في جزئيّ، وتسلّم المستأجر ذلك الجزئيّ فلا إشكال في أنّه بانقضاء مدّة الإجارة، أو المدّة التي يمكن فيها استيفاء المنفعة تلزم الاجرة، وتبرأ ذمّة المؤجر، مع نوع تأمّلٍ في بعض فروض تعيين العمل بغير المدّة تعرف ممّا سبق، فتأمّل.
وإن امتنع من التسلّم فالظاهر سقوط ضمان المعاوضة به، مع مضيّ زمان إمكان استيفاء المنفعة، لأنّه لا يعتبر فيه أزيد من التخلية، فلو تعذّر التسليم بعد ذلك لم يكن للمستأجر خيار التعذّر.
وأمّا براءة الذمّة، فللمؤجر الرجوع الى الحاكم، فيلزم المستأجر بقبول المبدول له، فإن امتنع قبل عنه، وإنّما قلنا: إنّه يلزمه بالقبول، لأنّ الحاكم يتولّى ما لا يمكن، وقبوله بالإلزام ممكن.
وإن تعذّر الرجوع الى الحاكم قام مقامه عدول المؤمنين، وإن تعذر الرجوع اليهم كان تعيين المؤجر كافياً، لا بمعنى انتقال الكلّيّ الى الخارج، بل بمعنى أنّه متعلّق
حقّ المستأجر بذلك الجزئي، فللمؤجر الرجوع اليه، وتعيين غيره، وله تركه للمستأجر، فبمضيّ مدّة الإجارة تبرأ الذمّة.
والدليل على ما قلنا هو لزوم اشتغال ذمّة المؤجر، بل كلّ مديون عليه، وعدم تمكّنه من تعريفها ضرر عليه.
ثمّ إنّه ربّما يطالب الفرق بين باب الإجارة والبيع، حيث أنّهم حكموا في الأخير بوجوب الرجوع الى الحاكم مهما أمكن.
والجواب: أن الرجوع اليه لتفريغ الذمّة واجب في المقامين، ولأجل لزوم الاجرة لا معنى له في المقامين، لأنّ ملاكه - وهو التخلية - حاصل بدون الرجوع اليه. قوله: ولو استأجر.
ولقد فرغت من تسويد هذه الرسالة من نسخته المباركة، التي بخطّه الشريف، في ٢٦ محرّم الحرام، في سنة ١٣٥٤ - هادي بن عبّاس بن محمد الطباطبائي الأصفهانيّ.
الفهرس
الرسائل الفشاركية الفقيه المحقق آية الله العظمى السيد محمد الفشاركي ١
الرسائل الفشاركية الفقيه المحقق آية الله العظمى السيد محمد الفشاركي ٣
نبذة من حياة السيد الفشاركي أعلى اللّه مقامه مولده: نشأته العلمية: ٦
عودته الى النجف: ٧
سجاياه الحميدة: ٨
مشايخه: تلاميذه: ٩
مصنّفاته: أولاده: ١٠
كراماته: وفاته: ١١
مصادر الترجمة ١٣
عملنا في التحقيق: ١٤
فائدة في أصالة البراءة ١٥
الكلام في الشبهة الحكمية التحريمية ٢٤
القول في أدلّة القول بوجوب الاحتياط والكفّ عمّا يحتمل حرمته وهي الكتاب والسنّة والعقل ٧٤
القول فيما إذا علم بالتحريم بين امور محصورة الأوّل ٨٧
المقام الثاني في وجوب الموافقة القطعية ٩٧
تنبيهات ١٠٥
القول في الشبهة الغير المحصورة أمّا الأوّل ١١٦
الكلام في الشك في الجزئية ١٢٤
مسألة ١٣٨
مسألة ١٤٠
مسألة ١٤٢
الشك في الشرطية مسألة ١٤٣
وأمّا الأدلّة النقلية ١٤٦
مسألة مسألة مسألة ١٤٧
الكلام في الزيادة مسألة ١٥٤
مسألة ١٧٤
القول في كيفية معذورية الجاهل في مسألة القصر والاتمام والجهر وأخيه ١٨٠
القول في الفحص ١٩١
رساله في تقوّي السافل بالعالي ١٩٥
رسالة في الدماء الثلاثة - الحيض وأحكامه ٢٢٣
حجّة القائلين بالوجوب امور ٢٦٦
الاستحاضة وأحكامها ٣٣٧
مسألة ٣٤٢
مسألة ٣٤٣
المسألة الثانية ٣٥٥
المسألة الثالثة ٣٥٧
رسالة في أحكام الخلل في الصلاة الفصل الخامس في السهو ٣٦٣
مسائل ٤١٥
رسالة في الخيارات القول في الخيارات ٤٤٥
مقدمة ٤٤٧
القول في أقسام الخيار - الاول خيار المجلس ٤٥٤
وهي كثير: ٤٥٤
فرع ٤٥٨
الثاني - خيار الحيوان ٤٦٩
المسألة الثالثة: ٤٧٥
الثالث من الخيارات - خيار الشرط ٤٨٥
فرع ٤٩٣
فرع ٤٩٣
مسائل ٤٩٩
القول في خيار الغبن ٥٣٥
رسالة في الاجارة ٥٦٤
الفهرس ٦٠٢