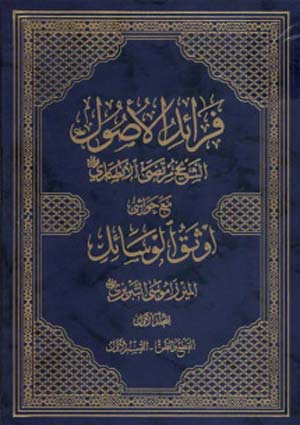بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين الحمد لله الذي هدانا إلى شرائع الاسلام بتمهيد قواعد الاحكام، وأرشدنا إلى غاية المرام باتباع مسالك الافهام، ووفقنا لتحصيل فصول الاصول باتقان ضوابط شريعة خير الانام، وبلغنا إلى نهاية المسؤول بإحكام قوانين الاحكام.
والصلاة والسلام على المبعوث لاعلاء دعائم الاسلام و إعلان معالم الحلال والحرام، وآله وأصحابه البررة، مفاتيح الرحمة ومصابيح الظلام.
أما بعد، فيقول أقل خدام الشريعة، أحوج الورى، عبدالحسين بن محمد بن رضا التستري - عفى الله تعالى عنهما -: إن هذا تصنيف شريف، وتأليف منيف، من جملة تصانيف المولى القمقام، وقدوة الانام فحل الاعلام، وفريد الايام، الخائض في أسرار المدارك، والغائص في بحار المسالك، ممهد القواعد، وجامع المقاصد، كاشف رموز الدالائل، نخبة الاواخر والاوائل، مقباس مناهج غاية المرام، ومشكاة مسالك إرشاد العوام، مهذب القوانين المحكمة، ومحرر الاشارات المبهمة، منبع الفضل، وعين العدل، فاتح صحيفة السداد والرشاد، وخاتم رقيمة الفضل والفقاهة والاجتهاد، رئيس المحققين والمدققين من الاولين والآخرين، شمس الفقهاء والمجتهدين، مرتضى المصطفى، و مصطفى المرتضى، كهف الحاج، شيخنا واستاذنا، علم التقى، الحاج شيخ مرتضى الانصاري التستري - مد الله تعالى أطناب ظلاله على مفارق الانام، وعمر الله بوجوده الشريف دوارس شرع الاسلام، ما دامت الفروع مترتبة على الاصول، والشمس لها الطلوع والافول.
ثم إنه دام ظله العالى لما أودع فيه نقود الحقائق وفرائد درر الدقائق، وأدرج فيه من مهمات مسائل الاصول ما لم يذكر في أبواب ولا فصول، وأجاد ما أفاد فيه من المطالب الابكار ما لم تصل إليها نتائج الافكار، كثر رغبة المشتغلين إلى إدراكها، وإشتد ميل المحصلين إلى فهمها.
ولما كان بعضهم ما اهتدوا بنور التوفيق إلى ما فيه من التدقيق والتحقيق، سألوني أن أعلق عليه وأضيف إليه ما استفدته حين قراءتي عليه - دام ظله العالي - بيانا للكتاب وتقريبا للمدعى إلى الحق والصواب، وكان مع إختصاره وسهولة إستنساخه واكتثاره في غاية العزة والندرة، ولا يكاد أيدي الكتاب تكفي لكفايته، مع ما بهم من السعي في تكثير كتابته، وكان إنطباعه موجبا للشياع وباعثا على مزيد الانتفاع، فبادر بعض من ساعده التوفيق بعد إطلاعه إلى إكثاره باطباعه، ولامتياز ما فيه من المطالب وجودة ما احتوى من العجائب سمي ب " فرائد الاصول " في تمييز المزيف عن المقبول.
رزقنا الله وإياه حسن المآب، إنه هو الكريم الوهاب، بحق محمد وآله الاطياب.
قال:بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أن المكلف إذا إلتفت إلى حكم شرعي، فإما أن يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن.
فإن حصل له الشك فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل، وتسمى بالاصول العملية.
وهي منحصرة في أربعة، لان الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا.
وعلى الثاني، فإما أن يمكن الاحتياط أم لا.
وعلى الاول، فإما أن يكون الشك في التكليف أو في المكلف به.
فالاول مجرى الاستصحاب، والثاني مجرى التخيير، والثالث مجرى أصالة البراءة، والرابع مجرى قاعدة الاحتياط.
[ فالاول مجرى الاستحصاب، والثاني مجرى أصالة البراءة، والثالث مجرى قاعدة الاحتياط، والرابع مجرى قاعدة التخيير.خ ل ].
[ وبعبارة أخرى: الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا.
فالاول مجرى الاستصحاب، والثاني إما أن يكون الشك فيه في التكليف أو لا.
فالاول مجرى أصالة البراءة، والثاني إما أن يمكن الاحتياط فيه أو لا.
فالاول مجرى قاعدة الاحتياط، والثاني مجرى قاعدة التخيير.نسخة ].
وما ذكرنا هو المختار في مجاري الاصول الاربعة، وقد وقع الخلاف فيها، وتمام الكلام في كل واحد موكول إلى محله.
فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة: الاول في القطع، والثاني في الظن، والثالث في الاصول العملية المذكورة التي هي مرجع عند الشك.
المقصد الاول في القطع
مقدمة
فنقول: لا إشكال في وجوب متابعة القطع والعمل عليه ما دام موجودا، لانه بنفسه طريق إلى الواقع.
وليس طريقيته قابلة لجعل الشارع إثباتا أو نفيا.
ومن هنا يعلم أن إطلاق الحجة عليه ليس كإطلاق الحجة على الامارات المعتبرة شرعا، لان الحجة عبارة عن الوسط الذي به يحتج على ثبوت الاكبر للاصغر، ويصير واسطة للقطع بثبوته له، كالتغير لاثبات حدوث العالم.
فقولنا: (الظن حجة، أو البينة حجة، أو فتوى المفتي حجة)، يراد به كونه هذه الامور أوساطا لاثبات أحكام متعلقاتها.
فيقال: هذا مظنون الخمرية، وكل مظنون الخمرية يجب الاجتناب عنه.
وكذلك قولنا: هذا الفعل مما أفتى المفتي بتحريمه، أو قامت البينة على كونه محرما، وكل ما كان كذلك فهو حرام.
وهذا بخلاف القطع، لانه إذا قطع بوجوب شئ فيقال: هذا واجب، وكل واجب يحرم ضده أو يجب مقدمته.
وكذلك العلم بالموضوعات.
فإذا قطع بخمرية شئ، فيقال: هذا خمر، وكل خمر يجب الاجتناب عنه.
ولا يقال: إن هذا معلوم الخمرية، وكل معلوم الخمرية حكمه كذا.
لان احكام الخمر إنما تثبت للخمر، لا لما علم أنه خمر.
والحاصل أن كون القطع حجة غير معقول، لان الحجة ما يوجب القطع بالمطلوب، فلا يطلق على نفس القطع.
هذا كله بالنسبة إلى حكم متعلق القطع، وهو الامر المقطوع.
وأما بالنسبة إلى حكم آخر، فيجوز أن يكون القطع مأخوذا في موضوعه، فيقال: إن الشئ المعلوم، بوصف كونه معلوما، حكمه كذا.
وحينئذ فالعلم يكون وسطا لثبوت ذلك الحكم لمتعلقه وإن لم يطلق عليه الحجة، إذ المراد
بالحجة في باب الادلة ما كان وسطا لثبوت أحكام متعلقة شرعا، لا لحكم آخر.
كما إذا رتب الشارع الحرمة على الخمر المعلوم كونهاخمرا، لا على نفس الخمر، وكترتب وجوب الاطاعة عقلا على معلوم الوجوب، لاالواجب الواقعي.
وبالجملة فالقطع قد يكون طريقا للحكم ن وقد يكون مأخوذا في موضوع الحكم.
* * *
ثم ما كان منه طريقا لا يفرق فيه بين خصوصياته من حيث القاطع به وأسباب القطع وأزمانه، إذ المفروض كونه طريقا إلى متعلقه، فيترتب عليه أحكام متعلقه، ولا يجوز للشارع أن ينهى عن العمل به، لانه مستلزم للتناقض.
فإذا قطع كون مائع بولا، من أي سبب كان، فلا يجوز للشارع أن يحكم بعدم نجاسته أو عدم وجوب الاجتناب عنه، لان المفروض أنه بمجرد القطع يحصل له صغرى وكبرى، أعني قوله: (هذا بول، وكل بول يجب الاجتناب عنه، فهذا يجب الاجتناب عنه).
فحكم الشارع بأنه لا يجب الاجتناب عنه مناقض له، إلا إذا فرض عدم كون النجاسة ووجوب الاجتناب من أحكام نفس البول، بل من أحكام ماعلم بوليته على وجه خاص من حيث السبب أو الشخص أو غيرهما، [ فخرج العلم حينئذ عن كونه طريقا ] ويكون مأخوذا في الموضوع.
وحكمه أن يتبع في إعتباره مطلقا أو على وجه خاص دليل ذلك الحكم الثابت الذي أخذ العلم في موضوعه.
فقد يدل على ثبوت الحكم لشئ بشرط العلم به، بمعنى إنكشافه للمكلف من غير خصوصية للانكشاف.
كما في حكم العقل بحسن إتيان ما قطع العبد بكونه مطلوبا لمولاه، وقبح ما يقطع بكونه مبغوضا، فإن مدخلية القطع بالمطلوبية أو المبغوضية في صيرورة الفعل حسنا أو قبيحا عند العقل لا يختص ببعض أفراده.
وكما في حكم الشرع بحرمة ما علم أنه خمر أو نجاسته بقول مطلق بناء على أن الحرمة والنجاسة الواقعيتين إنما تعرضان مواردهما بشرط العلم، لا في نفس الامر، كما هو قول بعض.
وقد يدل دليل ذلك الحكم على ثبوته لشئ بشرط حصول القطع به من سبب خاص او شخص خاص، مثل ما ذهب إليه بعض الاخباريين من عدم جواز العمل في الشرعيات بالعلم الغير الحاصل من الكتاب والسنة، كما سيجئ، وما ذهب إليه بعض من منع عمل القاضي بعلمه في حقوق الله تعالى.
وأمثلة ذلك بالنسبة إلى حكم غير القاطع كثيرة، كحكم الشارع على المقلد بوجوب الرجوع إلى
الغير في الحكم الشرعي إذا علم به من الطرق الاجتهادية المعهودة.
لا من مثل الرمل والجفر، فإن القطع الحاصل من هذه وإن وجب على القاطع الاخذ به في عمل نفسه، إلا أنه لا يجوز للغير تقليده في ذلك.
وكذلك العلم الحاصل للمجتهد الفاسق او غير الامامى من الطرق الاجتهادية المتعارفة، فانه لايجوز للغيرالعمل بها، وكحكم الشارع على الحاكم بوجوب بوجوب قبول خبر العدل المعلوم له من الحس، لا من الحدس، إلى غير ذلك.
* * *
ثم من خواص القطع الذي هو طريق إلى الواقع قيام الامارات الشرعية والاصول العملية مقامه في العمل، بخلاف المأخوذ في الحكم على وجه الوضوعية، فإنه تابع لدليل ذلك الحكم.
فإن ظهر منه أو من دليل خارج إعتباره على وجه الطريقية للموضوع - كالامثلة المتقدمة - قامت الامارات والاصول مقامه.
وإن ظهر منه إعتبار القطع في الموضوع من حيث كونها صفة خاصة قائمة بالشخص لم يقم مقامه غيره.
كما إذا فرضنا أن الشارع إعتبر صفة القطع على هذا الوجه في حفظ عدد الركعات الثنائية والثلاثية والاوليين من الرباعية.
فإن غيره، كالظن بأحد الطرفين أو أصالة عدم الزائد، لا يقوم مقامه إلا بدليل خاص خارجي غير أدلة حجية مطلق الظن في الصلاة وأصالة عدم الاكثر.
ومن هذا الباب عدم جواز أداء الشهادة إستنادا إلى البينة أو اليد على قول، وإن جاز تعويل الشاهد في عمل نفسه بهما إجماعا، لان العلم بالمشهود به مأخوذ في مقام العمل على وجه الطريقية، بخلاف مقام أداء الشهادة، إلا أن يثبت من الخارج أن كل ما يجوز العمل به من الطرق الشرعية يجوز الاستناد إليه في الشهادة، كما يظهر من رواية حفص الواردة في جواز الاستناد إلى اليد.
ومما ذكرنا يظهر أنه لو نذر أحد أن يتصدق كل يوم بدرهم ما دام متيقنا بحياة ولده، فإنه لا يجب التصدق عند الشك في الحياة، لاجل إستصحاب الحياة، بخلاف ما لو علق النذر بنفس الحياة، فإنه يكفي في الوجوب الاستصحاب.
* * *
ثم إن هذا الذي ذكرنا من كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقية وأخرى على وجه الموضوعية، جار في الظن أيضا.
فإنه وإن فارق العلم في كيفية الطريقية - حيث أن العلم طريق بنفسه، والظن المعتبر طريق بجعل الشارع، بمعنى كونه وسطا في ترتب أحكام متعلقه، كما أشرنا إليه سابقا - لكن الظن قد يؤخذ طريقا مجعولا إلى متعلقه، وقد يؤخذ موضوعا للحكم، [ سواء كان موضوعا على
وجه الطريقية لحكم متعلقه أو لحكم آخر يقوم مقامه سائر الطرق الشرعية، فيقال حينئذ إنه حجة، وقد يؤخذ موضوعا لا على وجه الطريقة لحكم متعلقه أو لحكم آخر ولا يطلق عليه الحجة ح ]، فلا بد من ملاحظة دليل ذلك ثم الحكم بقيام غيره من الطرق المعتبرة مقامه، لكن الغالب فيه الاول.
وينبغى التنبيه على أمور:
الامرالاول:هل القطع حجة سواء صادف الواقع أم لم يصادف
إنه قد عرفت أن القاطع لا يحتاج في العمل بقطعه إلى أزيد من الادلة المثبتة لاحكام مقطوعه، فيجعل ذلك كبرى لصغرى قطع بها فيقطع بالنتيجة.
فإذا قطع بكون شئ خمرا وقام الدليل على كون حكم الخمر في نفسها هي الحرمة فيقطع بحرمة ذلك الشئ.
لكن الكلام في أن قطعه هذا هل هو حجة عليه من الشارع وإن كان مخالفا للواقع في علم الله فيعاقب على مخالفته، أو أنه حجة عليه إذا صادف الواقع؟، بمعنى أنه لو شرب الخمر الواقعي عالما عوقب عليه، في مقابل من شربها جاهلا، لا أنه يعاقب على شرب ما قطع بكونه خمرا وإن لم يكن خمرا في الواقع.
ظاهر كلماتهم في بعض المقامات الاتفاق على الاول، كما يظهر، من دعوى جماعة الاجماع على أن ظان ضيق الوقت إذا أخر الصلاة عصى وإن إنكشف بقاء الوقت، فإن تعبيرهم بظن الضيق لبيان أدنى فردي الرجحان، فيشمل القطع بالضيق.
نعم حكي عن النهاية وشيخنا البهائي التوقف في العصيان، بل في التذكرة: (لو ظن ضيق الوقت عصى لو أخر إن إستمر الظن، وإن إنكشف خلافه فالوجه عدم العصيان)، إنتهى.
واستقرب العدم سيد مشايخنا في المفاتيح.
وكذا لا خلاف بينهم ظاهرا في أن سلوك المظنون الخطر أو مقطوعه معصية يجب إتمام الصلاة فيه ولو بعد إنكشاف عدم الضرر فيه، فتأمل.ويؤيده بناء العقلاء على الاستحقاق وحكم العقل بقبح التجري.
وقد يقرر دلالة العقل على ذلك: بأنا إذا فرضنا شخصين قاطعين بأن قطع أحدهما بكون مائع معين خمرا وقطع الاخر بكون مائع آخر خمرا فشرباهما، فاتفق مصادفة أحدهما للواقع ومخالفة الاخر، فإما أن يستحقا العقاب، أو لا يستحقه أحدهما، أو يستحقه من صادف قطعه الواقع دون الاخر، أو العكس.
لا سبيل إلى الثاني والرابع، والثالث مستلزم لاناطة إستحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار، وهو مناف لما يقتضيه العدل، فتعين الاول.ويمكن الخدشة في الكل.
أما الاجماع، فالمحصل منه غير حاصل، والمسألة عقلية، خصوصا مع مخالفة غير واحد، كما عرفت من النهاية وستعرف من قواعد الشهيد، قدس سره، والمنقول منه ليس حجة في المقام.
وأما بناء العقلاء، فلو سلم فإنما على مذمة الشخص من حيث أن هذا الفعل يكشف عن وجود صفة الشقاوة فيه، لا على نفس فعله، كمن إنكشف لهم من حاله أنه بحيث لو قدر على قتل سيده لقتله، فإن المذمة على المنكشف، لا الكاشف.
ومن هنا يظهر الجواب على قبح التجري، فإنه لكشف ما تجري به عن خبث الفاعل لكونه جريئا عازما على العصيان والتمرد، لا عن كون الفعل مبغوضا للمولى.
والحاصل: أن الكلام في كون هذا الفعل الغير المنهي عنه واقعا، مبغوضا للمولى من حيث تعلق إعتقاد المكلف بكونه مبغوضا، لا في أن هذا الفعل المنهى عنه باعتقاد ينبئ عن سوء سريرة العبد مع سيده وكونه جريئا في مقام الطغيان والمعصية وعازما عليه، فإن هذا غير منكر في هذا المقام، كما سيجئ، ولكن لا يجدي في كون الفعل محرما شرعيا، لان إستحقاق المذمة على ما كشف عنه الفعل لا يوجب إستحقاقه على نفس الفعل، ومن المعلوم أن الحكم العقلي بإستحقاق الذم إنما يلازم إستحقاق العقاب شرعا إذا تعلق بالفعل، لا بالفاعل.
وأما ما ذكر من الدليل العقلي فنلتزم بإستحقاق من صادف قطعه الواقع، لانه عصى إختيارا، دون من لم يصادف.
قولك: (إن التفاوت بالاستحقاق والعدم لا يحسن أن يناط بما هو خارج عن الاختيار)، ممنوع، فإن العقاب بما لا يرجع بالاخرة إلى الاختيار قبيح، إلا أن عدم العقاب لامر لا يرجع إلى الاختيار قبحه غير معلوم.
كما يشهد به الاخبار الواردة في أن: (من سن سنة حسنة كان له مثل أجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة كان له مثل وزر من عمل بها).
فإذا فرضنا ان شخصين سنا سنة حسنة أو سيئة، واتفق كثرة العامل بأحدهما وقلة العامل بما سنه الاخر، فإن مقتضى الروايات كون ثواب الاول أو عقابه أعظم، وقد إشتهر: (أن للمصيب أجرين وللمخطئ أجرا واحدا).
والاخبار في أمثال ذلك في طرفي الثواب والعقاب بحد التواتر.
فالظاهر أن العقل إنما يحكم بتساويهما في إستحقاق المذمة من حيث شقاوة الفاعل وخبث سريرته مع المولى، لا في إستحقاق المذمة على الفعل المقطوع بكونه معصية.
وربما يؤيد ذلك أنا نجد من أنفسنا الفرق في مرتبة العقاب بين من صادف فعله الواقع و بين من لم يصادف.
إلا أن يقال: إن ذلك إنما هو في المبغوضات العقلائية من حيث أن زيادة العقاب من المولى وتأكد الذم من العقلاء بالنسبة إلى من صادف إعتقاده الواقع لاجل التشفي المستحيل في حق الحكيم تعالى، فتأمل، هذا.
وقد يظهر من بعض المعاصرين: (التفصيل في صورة القطع بتحريم شئ غير محرم واقعا، فرجح إستحقاق العقاب بفعله، إلا أن يعتقد تحريم واجب غير مشروط بقصد القربة، فإنه لا يبعد عدم إستحقاق العقاب عليه مطلقا أو في بعض الموارد نظرا إلى معارضة الجهة الواقعية للجهة الظاهرية، فإن قبح التجري عندنا ليس ذاتيا، بل يختلف بالوجوه والاعتبارات.
فمن إشتبه عليه مؤمن ورع بكافر واجب القتل، فحسب أنه ذلك الكافر و تجرى فلم يقتله، فإنه لا يستحق الذم على هذا الفعل عقلا عند من إنكشف له الواقع، وإن كان معذورا لو فعل.
وأظهر من ذلك ما لو جزم بوجوب قتل نبي أو وصي فتجرى ولم يقتله.
ألا ترى أن المولى الحكيم إذا أمر عبده بقتل عدو له فصادف العبد إبنه وزعمه ذلك العدو فتجرى ولم يقتله، أن المولى إذا إطلع على حاله لا يذمه على هذا التجري بل يرضى به، وإن كان معذورا لو فعل.
وكذا لو نصب له طريقا غير القطع إلى معرفة عدوه، فأدى الطريق إلى تعيين إبنه فتجرى ولم يفعل.
وهذا الاحتمال حيث يتحقق عند المتجري لا يجديه إن لم يصادف الواقع، ولذا يلزمه العقل بالعمل بالطريق المنصوب، لما فيه من القطع بالسلامة من العقاب.بخلاف ما لو ترك العمل به، فإن المظنون فيه عدمها.
ومن هنا يظهر أن التجري على الحرام في المكروهات الواقعية أشد منه في مباحاتها، وهو فيها أشد منه في مندوباتها، ويختلف بإختلافها ضعفا وشدة كالمكروهات.
ويمكن أن يراعى في الواجبات الواقعية ما هو الاقوى من جهاته وجهات التجري) إنتهى كلامه رفع مقامه.
أقول: يرد عليه، أولا، منع ما ذكره من عدم كون قبح التجري ذاتيا، لان التجري على المولى قبيح ذاتا، سواء كان لنفس الفعل ولكشفه عن كونه جريئا [ كالظلم، بل هو قسم من الظلم ]، فيمتنع عروض الصفة المحسنة، وفي مقابله الانقياد لله سبحانه، فإنه يمتنع أن يعرض له جهة مقبحة.
وثانيا، أنه لو سلم أنه لا إمتناع في أن يعرض له جهة محسنة، لكنه باق على قبحه ما لم يعرض له تلك الجهة، وليس مما لا يعرض في نفسه حسن ولا قبح إلا بملاحظة ما يتحقق في ضمنه.
و بعبارة أخرى: لو سلمنا عدم كونه علة تامة للقبح، كالظلم، فلا شك في كونه مقتضيا له، كالكذب، وليس من قبيل الافعال التي لا يدرك العقل بملاحظتها في أنفسها حسنها ولا قبحها.
وحينئذ فيتوقف إرتفاع قبحه على إنضمام جهة يتدارك بها قبحه، كالكذب المتضمن لانجاء نبي.
ومن المعلوم أن ترك قتل المؤمن - بوصف أنه مؤمن في المثال الذي ذكره كفعله ليس من الامور التي تتصف بحسن أو قبح، للجهل بكونه قتل مؤمن.ولذا إعترف في كلامه بأنه لو قتله كان معذورا.
فإذا لم يكن هذا الفعل الذي تحقق التجري في ضمنه مما يتصف بحس أو قبح، لم يؤثر في إقتضاء ما يقتضي القبح، كما لا يؤثر في إقتضاء ما يقتضي الحسن لو فرض أمره بقتل كافر فقتل مؤمنا معتقدا كفره، فإنه لا إشكال في مدحه من حيث الانقياد وعدم مزاحمة حسنه بكونه في الواقع قتل مؤمن.
ودعوى: (أن الفعل الذي يتحقق به التجري وإن لم يتصف في نفسه بحسن ولا قبح لكونه مجهول العنوان، لكنه لا يمتنع أن يؤثر في قبح ما يقتضي القبح بأن يرفعه، إلا أن نقول بعدم مدخلية الامور الخارجة عن القدرة في إستحقاق المدح والذم، وهو محل نظر بل منع.
وعليه يمكن إبتناء منع الدليل العقلي السابق في قبح التجري)، مدفوعة - مضافا إلى الفرق بين ما نحن فيه وبين ما تقدم
من الدليل العقلي، كما لا يخفى على المتأمل بأن العقل مستقل بقبح التجري في المثال المذكور.
و مجرد تحقق ترك قتل المؤمن في ضمنه، مع الاعتراف بأن ترك القتل لايتصف بحسن لا قبح، لا يرفع قبحه، ولذا يحكم العقل بقبح الكذب وضرب اليتيم إذا إنضم إليهما ما يصرفهما إلى المصلحة إذا جهل الفاعل بذلك.
ثم إنه ذكر هذا القائل في بعض كلماته: (أن التجري إذا صادف المعصية الواقعية تداخل عقابهما).
ولم يعلم معنى محصل لهذا الكلام، إذ مع كون التجري عنوانا مستقلا في إستحقاق العقاب لا وجه للتداخل إن أريد به وحدة العقاب، فإنه ترجيح بلا مرجح.
وسيجئ في الرواية أن على الراضي إثما وعلى الداخل إثمين، وإن أريد به عقاب زائد على عقاب محض التجري، فهذا ليس تداخلا، لن كل فعل إجتمع فيه عنوانان من القبح يزيد عقابه على ما كان فيه أحدهما.
* * *
والتحقيق أنه لا فرق في قبح التجري بين موارده وأن المتجري لا إشكال في إستحقاقه الذم من جهة إنكشاف خبث باطنه وسوء سريرته بذلك.
وأما إستحقاقه للذم من حيث الفعل المتجرى في ضمنه، ففيه إشكال، كما إعترف به الشهيد، قدس سره، فيما يأتي من كلامه.
نعم لو كان التجري على المعصية بالقصد إلى المعصية، فالمصرح به في الاخبار الكثيرة العفو عنه، وإن كان يظهر من أخبار أخر العقاب على القصد أيضا: مثل قوله صلى الله عليه وآله: (نية الكافر شر من عمله)، وقوله: (إنما يحشر الناس على نياتهم).
وما ورد من تعليل خلود أهل النار في النار وخلود أهل الجنة في الجنة بعزم كل من الطائفتين على الثبات على ما كان عليه من المعصية والطاعة لو خلدوا في الدنيا.
وماورد من: (أنه إذا إلتقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار.
قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول، قال: لانه أراد قتل صاحبه) ومنا ورد في العقاب على فعل بعض المقدمات بقصد ترتب الحرام، كغارس الخمر والماشي
لسعاية مؤمن.
وفحوى ما دل على أن الرضا بفعل كالفعل، مثل قوله عليه السلام: (الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، وعلى الداخل إثمان إثم الرضا وإثم الدخول) ويؤيده قوله تعالى: (إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله).
وما ورد أن: (من رضي بفعل فقد لزمه وإن لم يفعل).
وما ورد في تفسير قوله تعالى: (فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين)، من أن نسبة القتل إلى المخاطبين مع تأخرهم عن القائلين بكثير لرضاهم بفعلهم.
ويؤيده قوله تعالى: (تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين)، وقوله تعالى: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم).
ويمكن حمل الاخبار الاول على من إرتدع عن قصده بنفسه، وحمل الاخبار الاخيرة على من بقي على قصده حتى عجز عن الفعل لا باختياره.
أو يحمل الاول على من إكتفى بمجرد القصد، والثانية على من إشتغل بعد القصد ببعض المقدمات، كما يشهد له حرمة الاعانة على المحرم، حيث عممه بعض الاساطين لاعانة نفسه على الحرام، ولعله لتنقيح المناط، لا للدلالة اللفظية.
* * *
وقد علم مما ذكرنا أن التجري على أقسام يجمعها عدم المبالاة بالمعصية أو قلتها.
أحدها مجرد القصد إلى المعصية، والثاني القصد مع الاشتغال بمقدماته، والثالث القصد مع التلبس بما يعتقد كونه معصية، والرابع التلبس بما يحتمل كونه معصية رجاء لتحقق المعصية به، والخامس التلبس به لعدم المبالاة بمصادفة الحرام، والسادس التلبس به رجاء أن لا يكون معصية وخوف أن يكون معصية.
ويشترط في صدق التجري في الثلاثة الاخيرة عدم كون الجهل عقليا أو شرعيا، كما في الشبهة المحصورة الوجوبية أو التحريمية، وإلا لم يتحقق إحتمال المعصية وإن تحقق إحتمال المخالفة للحكم الواقعي، كما في موارد أصالة البراءة وإستصحابها.
ثم إن الاقسام الستة كلها مشتركة في إستحقاق الفاعل للمذمة من حيث خبث ذاته وجرأته
وسوء سريرته، وإنما الكلام في تحقق العصيان بالفعل المتحقق في ضمنه التجري.
وعليك بالتأمل في كل من الاقسام.
قال الشهيد، رحمه الله، في القواعد: (لا يؤثر نية المعصية عقابا ولا ذما ما لم يتلبس بها.
وهو مما ثبت في الاخبار العفو عنه.
ولو نوى المعصية وتلبس بما يراه معصية فظهر خلافها، ففي تأثير هذه النية نظر، من أنها لما لم تصادف المعصية صارت كنية مجردة وهي غير مؤاخذ بها، ومن دلالتها على إنتهاك الحرمة وجرأته على المعاصي.
وقد ذكر بعض الاصحاب أنه لو شرب المباح تشبها بشرب السكر فعل حراما.
ولعله ليس لمجرد النية، بل بإنضمام فعل الجوارح.
ويتصور محل النظر في صور: منها: ما لو وجد إمرأة في منزل غيره، فظنها أجنبية فأصبها، فبان أنها زوجته أو أمته.
ومنها: ما لو وطئ زوجته بظن أنها حائض فبانت طاهرة.
ومنها: لو هجم على طعام بيد غيره فأكله، فتبين أنه ملكه.
ومنها: لو ذبح شاة بظنها للغير بقصد العدوان، فظهرت ملكه.
ومنها: ما إذا قتل نفسا بظن أنها معصومة، فبانت مهدورة.
وقد قال بعض العامة: (نحكم بفسق المتعاطي ذلك، لدلالته على عدم المبالاة بالمعاصي، ويعاقب في الاخرة ما لم يتب عقابا متوسطا بين الصغيرة والكبيرة).
وكلاهما تحكم وتخرص على الغيب)، إنتهى.
الامرالثاني: هل القطع الحاصل من المقدمات العقلية حجة
إنك قد عرفت أنه لا فرق فيما يكون العلم فيه كاشفا محضا بين أسباب العلم.
وينسب إلى غير واحد من أصحابنا الاخباريين عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدمات العقلية القطعية الغير الضرورية، لكثرة وقوع الاشتباه والغلط فيها، فلا يمكن الركون إلى شئ منها.
فإن أرادوا عدم جواز الركون بعد حصول القطع، فلا يعقل ذلك في مقام إعتبار العلم من حيث الكشف، ولو أمكن الحكم بعدم إعتباره لجرى مثله في القطع الحاصل من المقدمات الشرعية طابق النعل بالنعل.
وإن أرادوا عدم جواز الخوض في المطالب العقلية لتحصيل المطالب الشرعية لكثرة وقوع الغلط والاشتباه، فلو سلم ذلك وأغمض عن المعارضة، لكثرة ما يحصل من الخطأ في فهم المطالب من الادلة الشرعية، فله وجه.
وحينئذ فلو خاض فيها وحصل القطع بما لا يوافق الحكم الواقعي لم يعذر في ذلك، لتقصيره في مقدمات التحصيل، إلا أن الشأن في ثبوت كثرة الخطأ أزيد مما يقع في فهم المطالب من الادلة الشرعية.
وقد عثرت، بعدما ذكرت هذا، على كلام يحكى عن المحدث الاسترابادي في فوائده المدنية، قال في عداد ما استدل به على إنحصار الدليل في غير الضروريات الدينية في السماع عن الصادقين عليهم السلام، قال: (الدليل التاسع مبني على مقدمة دقيقة شريفة تفطنت بتوفيق الله تعالى.
وهي أن العلوم النظرية قسمان، قسم ينتهي إلى مادة هي قريبة من الاحساس، و من هذا القسم علم الهندسة والحساب وأكثر أبواب المنطق.
وهذا القسم لا يقع فيه الخلاف بين العلماء والخطأ في نتائج الافكار.والسبب في ذلك أن الخطأ في الفكر
إما من جهة الصورة أو من جهة المادة.
والخطأ من جهة الصورة لا يقع من العلماء، لان معرفة الصورة من الامور الواضحة عند الاذهان المستقيمة.
والخطأ من جهة المادة لا يتصور في هذه العلوم، لقرب المواد فيها إلى الاحساس.
وقسم ينتهي إلى مادة هي بعيدة عن الاحساس.
ومن هذا القسم الحكمة الالهية والطبيعية وعلم الكلام وعلم أصول الفقه والمسائل النظرية الفقهية وبعض القواعد المذكورة في كتب المنطق.
ومن ثم رفع الاختلافات والمشاجرات بين الفلاسفة في الحكمة الالهية والطبيعية وبين علماء الاسلام في اصول الفقه ومسائل الفقه وعلم الكلام وغير ذلك.
والسبب في ذلك أن القواعد المنطقية إنما هي عاصمة عن الخطأ من جهة الصورة لا من جهة المادة.
إذ أقصى مايستفاد من المنطق في باب مواد الاقيسة تقسيم المواد على وجه كلي إلى أقسام.
وليست في المنطق قاعدة بها يعلم أن كل مادة مخصوصة داخلة في أي قسم من الاقسام، ومن المعلوم عند أولي الالباب إمتناع وضع قاعدة تكفل بذلك).
ثم إستظهر ببعض الوجوه تأييدا لما ذكره، وقال بعد ذلك: (فإن قلت: لا فرق في ذلك بين العقليات والشرعيات.
والشاهد على ذلك ما نشاهده من كثرة الاختلافات الواقعة بين أهل الشرع في أصول الدين وفي الفروع الفقهية.
قلت: إنما نشأ ذلك من ضم مقدمة عقلية باطلة بالمقدمة النقلية الظنية أو القطعية ومن الموضحات لما ذكرناه من أنه ليس في المنطلق قانون يعصم عن الخطأ في مادة الفكر أن المشائيين إدعوا البداهة في أن تفريق ماء كوز إلى كوزين إعدام لشخصه وإحداث لشخصين آخرين.
وعلى هذه المقدمة بنوا إثبات الهيولى.
والاشراقيين إدعوا البداهة في أنه ليس إعداما للشخص الاول وإنما إنعدمت صفة من صفاته وهو الاتصال).
ثم قال: (إذا عرفت ما مهدناه من المقدمة الدقيقة الشريفة، فنقول: إن تمسكنا بكلامهم عليهم السلام فقد عصمنا من الخطأ، وإن تمسكنا بغيرهم
لم نعصم منه)، إنتهى كلامه.
والمستفاد من كلامه عدم حجية إدراكات العقل في غير المحسوسات وما تكون مباديه قريبة من الاحساس إذا لم يتوافق عليه العقول.
وقد إستحسن ما ذكره غير واحد ممن تأخر عنه، منهم السيد المحدث الجزائري، قدس سره، في أوائل شرح التهذيب، على ما حكي عنه.
قال بعد ذكر كلام المحدث المتقدم بطوله: (وتحقيق المقام يقتضي ما ذهب إليه.
فإن قلت: قد عزلت العقل عن الحكم في الاصول والفروع.
فهل يبقى له حكم في مسألة من المسائل؟ قلت: أما البديهيات فهي له وحده، وهو الحاكم فيها.
وأما النظريات فإن وافقه النقل وحكم بحكمه قدم حكمه على النقل وحده.
وأما لو تعارض هو والنقلي، فلا شك عندنا في ترجيح النقل وعدم الالتفات إلى ما حكم به العقل.
قال -: - وهذا أصل يبتنى عليه مسائل كثيرة.
ثم ذكر جملة من المسائل المتفرعة).
أقول: لا يحضرني شرح التهذيب حتى ألاحظ ما فرع على ذلك.
فليت شعري إذا فرض حكم العقل على وجه القطع بشئ كيف يجوز حصول القطع أو الظن من الدليل النقلي على خلافه.
و كذا لو فرض حصول القطع من الدليل النقلي كيف يجوز حكم العقل بخلافه على وجه القطع؟ وممن وافقهما على ذلك في الجملة المحدث البحراني في مقدمات الحدائق، حيث نقل كلاما للسيد المتقدم في هذا المقام واستحسنه، إلا أنه صرح بحجية العقل الفطري الصحيح وحكم بمطابقته للشرع ومطابقة الشرع له.
ثم قال: (لا مدخل للعقل في شئ من الاحكام الفقهية من عبادات وغيرها، ولا سبيل إليها إلا السماع عن المعصوم عليه السلام، لقصور العقل المذكور عن الاطلاع عليها).
ثم قال: (نعم يبقى الكلام بالنسبة إلى ما يتوقف على التوقيف، فنقول: إن كان الدليل العقلي المتعلق بذلك بديهيا ظاهر البداهة، مثل الواحد نصف الاثنين، فلا ريب في صحة العمل به.
وإلا فإن لم يعارضه دليل عقلي ولا نقلي فكذلك، وإن عاضره دليل عقلي آخر، فإن تأيد أحدهما بنقلي كان الترجيح
للمتأيد بالدليل النقلي، وإلا فإشكال.
وإن عارضه دليل نقلي، فإن تأيد ذلك العقلي بدليل نقلي كان الترجيح للعقلي، إلا أن هذا في الحقيقة تعارض في النقليات، وإلا فالترجيح للنقلي، وفاقا للسيد المحدث المتقدم ذكره وخلافا للاكثر.
هذا بالنسبة إلى العقلي بقول مطلق.
أما لو أريد به المعنى الاخص، وهو الفطري الخالي عن شوائب الاوهام الذي هو حجة من حجج الملك العلام وإن شذ وجوده في الانام ففي ترجيح النقلي عليه إشكال)، إنتهى.
ولا أدري كيف جعل الدليل النقلي في الاحكام النظرية مقدما على ما هو في البداهة من قبيل (الواحد نصف الاثنين).
مع أن ضروريات الدين والمذهب لم يزد في البداهة على ذلك.
والعجب مما ذكره في الترجيح عند تعارض العقل والنقل كيف يتصور الترجيح في القطعيين، وأي دليل على الترجيح المذكور.
وأعجب من ذلك الاستشكال في تعارض العقليين من دون ترجيح مع أنه لا إشكال في تساقطهما، وفي تقديم العقلى الفطري الخالي عن شوائب الاوهام على الدليل النقلي.
مع أن العلم بوجود الصانع إما أن يحصل من هذا العقل الفطري أو مما دونه من العقليات البديهية، بل النظريات المنتهية إلى البداهة.
والذي يقتضيه النظر، وفاقا لاكثر أهل النظر، أنه كلما حصل القطع من دليل عقلي فلا يجوز أن يعارضه دليل نقلي.
وإن وجد ما ظاهره المعارضة فلا بد من تأويله إن لم يمكن طرحه.
وكلما حصل القطع من دليل نقلي، مثل القطع الحاصل من إجماع جميع الشرائع على حدوث العالم زمانا، فلا يجوز أن يحصل القطع على خلافه من دليل عقلي، مثل إستحالة تخلف الاثر عن المؤثر.
ولو حصل منه صورة برهان كانت شبهة في مقابلة البديهة، لكن هذا لا يتأتى في العقل البديهي من قبيل (الواحد نصف الاثنين)، ولا في الفطري الخالي عن شوائب الاوهام.
فلا بد في مواردهما من إلتزام عدم حصول القطع من النقل على خلافه، لان الادلة القطعية النظرية في النقليات مضبوطة محصورة ليس فيها شئ يصادم العقل البديهي أو الفطري.
فإن قلت: لعل نظر هؤلاء في ذلك إلى ما يستفاد من الاخبار، مثل قولهم عليهم السلام: (حرام عليكم أن تقولوا بشئ ما لم تسمعوه منا)، وقولهم عليهم السلام: (ولو أن رجلا قام وليله وصام
نهاره وحج دهره وتصدق بجميع ماله ولم يعرف ولاية ولي الله فيكون أعماله بدلالته فيواليه، ما كان له على الله ثواب) وقولهمخ عليهم السلام: (من دان الله بغير سماع من صادق فهو كذا وكذا) إلى غير ذلك، من أن الواجب علينا هو إمتثال أحكام الله تعالى التي بلغها حججه عليهم السلام.
فكل حكم لم يكن الحجة واسطة في تبليغه لم يجب إمتثاله، بل يكون من قبيل (اسكتوا عما سكت الله عنه)، فإن معنى سكوته عنه عدم أمر أوليائه بتبليغه حينئذ.
فالحكم المنكشف بغير واسطة الحجة ملغى في نظر الشارع وإن كان مطابقا للواقع.
كما يشهد به تصريح الامام، عليه السلام، بنفي الثواب على التصدق بجميع المال، مع القطع بكونه محبوبا ومرضيا عند الله.
ووجه الاستشكال في تقديم الدليل النقلي على العقلي الفطري السليم ما ورد من النقل المتواتر على حجية العقل، وأنه حجة باطنة، وأنه مما يعبد به الرحمن ويكتسب به الجنان، ونحوها، مما يستفاد منه كون العقل السليم أيضا حجة من الحجج.
فالحكم المنكشف به حكم بلغه الرسول الباطني، الذي هو شرع من داخل، كما أن الشرع عقل من خارج.
ومما يشير إلى ما ذكرنا من قبل هؤلاء، ما ذكره السيد الصدر، رحمه الله، في شرح الوافية في جملة كلام له في حكم ما يستقل به العقل، ما لفظه: (إن المعلوم هو أنه يجب فعل شئ أو تركه أو لا يجب إذا حصل الظن أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما من جهة نقل قول المعصوم، عليه السلام، أو فعله أو تقريره، لا أنه يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع حصولهما من أي طريق كان)، إنتهى موضع الحاجة.
قلت: أولا، نمنع مدخلية توسط تبليغ الحجة في وجوب إطاعة حكم الله سبحانه.
كيف والعقل، بعدما عرف أن الله تعالى لا يرضى بترك الشئ الفلاني وعلم بوجوب إطاعة الله، لم يحتج ذلك إلى توسط مبلغ.
ودعوى إستفادة ذلك من الاخبار ممنوعة، فإن المقصود من أمثال الخبر المذكور عدم جواز الاستبداد بالاحكام الشرعية بالعقول الناقصة الظنية، على ما كان متعارفا في ذلك الزمان من العمل بالاقيسة والاستحسانات، من غير مراجعة حجج الله بل في مقابلهم عليهم السلام.
وإلا فإدراك العقل القطعي للحكم المخالف للدليل النقلي على وجه لا يمكن الجمع بينهما في غاية
الندرة بل لا نعرف وجوده، فلا ينبغي الاهتمام به في هذه الاخبار الكثيرة، مع أن ظاهرها ينفي حكومة العقل ولو مع عدم المعارض.
وعلى ما ذكرنا يحمل ما ورد من: (أن دين الله لا يصاب بالعقول).
وأما نفي الثواب على التصدق مع عدم كون العمل به بدلالة ولي الله، فلو أبقي على ظاهره دل على عدم الاعتبار بالعقل الفطري الخالي عن شوائب الاوهام، مع إعترافه بأنه حجة من حجج الملك العلام.
فلا بد من حمله على التصدقات الغير المقبولة، مثل التصدق على المخالفين، لاجل تدينهم بذلك الدين الفاسد، كما هو الغالب في تصدق المخالف على المخالف.
كما في تصدقنا على فقراء الشيعة، لاجل محبتهم لامير المؤمنين عليه السلام وبغضهم لاعدائه، أو على أن المراد حبط ثواب التصدق، من أجل عدم المعرفة لولي الله تعالى أو على غير ذلك.
وثانيا، سلمنا مدخلية تبليغ الحجة في وجوب الاطاعة.
لكنا إذا علمنا إجمالا بأن حكم الواقعة الفلانية لعموم الابتلاء بها قد صدر يقينا من الحجة مضافا إلى ما ورد من قوله، صلى الله عليه وآله، في خطبة حجة الوداع: (معاشر الناس ! ما من شئ يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا أمرتكم به، وما من شئ يقربكم إلى النار ويباعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه) ثم أدركنا ذلك الحكم إما بالعقل المستقل وإما بواسطة مقدمة عقلية، نجزم من ذلك بأن ما إستكشفناه بعقولنا صادر عن الحجة، صلوات الله عليه، فيكون الاطاعة بواسطة الحجة.
إلا أن يدعى: أن الاخبار المتقدمة وأدلة وجوب الرجوع إلى الائمة، صلوات الله عليهم، تدل على مدخلية تبليغ الحجة وبيانه في طريق الحكم، وأن كل حكم لم يعلم من طريق السماع عنهم عليهم السلام ولو بالواسطة، فهو غير واجب الاطاعة.
وحينئذ فلا يجدي مطابقة الحكم المدرك لما صدر عن الحجة عليه السلام.
لكن قد عرفت عدم دلالة الاخبار.
ومع تسليم ظهورها فهو أيضا من باب تعارض النقل الظني مع العقل القطعي.
ولذلك لا فائدة مهمة في هذه المسألة، إذ بعدما قطع العقل بحكم وقطع بعدم رضاء الله جل ذكره بمخالفته، فلا يعقل ترك العمل بذلك ما دام هذا القطع باقيا، فكل ما دل على خلاف ذلك فمؤول أو مطروح.
نعم، الانصاف أن الركون إلى العقل فيما يتعلق بإدراك مناطات الاحكام لينتقل منها إلى
إدراك نفس الاحكام موجب للوقوع في الخطأ كثيرا في نفس الامر، وإن لم يحتمل ذلك عند المدرك، كما يدل عليه الاخبار الكثيرة الواردة، بمضمون (إن دين الله لا يصاب بالعقول)، و (إنه لا شئ أبعد عن دين الله من عقول الناس).
وأوضح من ذلك كله رواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام: (قال: قلت له: رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة، كم فيها من الدية؟.
قال: عشر من الابل.
قال: قلت: قطع إصبعين؟ قال: عشرون.
قلت: قطع ثلاث، قال: ثلاثون.
قلت: قطع أربعا.
قال: عشرون.
قلت: سبحان الله ! يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون، كان يبلغنا هذا ونحن بالعراق، فقلنا: إن الذي جاء به شيطان.
قال عليه السلام: مهلا، يا أبان ! هذا حكم رسول الله " ص " إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغ الثلث رجع إلى النصفء يا أبان ! إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين).
وهي وإن كانت ظاهرة في توبيخ أبان على رد الرواية الظنية التي سمعها في العراق بمجرد إستقلال عقله بخلافه أو على تعبجه مما حكم به الامام عليه السلام، من جهة مخالفته لمقتضى القياس، إلا أن مرجع الكل إلى التوبيخ على مراجعة العقل في إستنباط الاحكام.
فهو توبيخ على المقدمات المفضية إلى مخالفة الواقع.
وقد أشرنا، هنا وفي أول المسألة، إلى عدم جواز الخوض لاستكشاف الاحكام الدينية في المطالب العقلية والاستعانة بها في تحصيل مناط الحكم والانتقال منه إليه على طريق اللم، لان أنس الذهن بها يوجب عدم حصول الوثوق بما يصل إليه من الاحكام التوقيفية، فقد يصير منشأ لطرح الامارات النقلية الظنية، لعدم حصول الظن له منها بالحكم.
وأوجب من ذلك ترك الخوض في المطالب العقلية النظرية لادراك ما يتعلق بأصول الدين، فإنه تعريض للهلاك الدائم والعذاب الخالد.
وقد أشير إلى ذلك عند النهى عن الخوض في مسألة القضاء والقدر، وعند نهي بعض أصحابهم، عليهم السلام، عن المجادلة في المسائل الكلامية.
لكن الظاهر من بعض تلك الاخبار أن الوجه في النهي عن الاخير عدم الاطمينان بمهارة الشخص المنهي في المجادلة، فيصير مفحما عند المخالفين ويوجب ذلك وهن المطالب الحقة في نظر أهل الخلاف.
الامرالثالث: قد إشتهر في ألسنة المعاصرين أن قطع القطاع لا إعبار به
ولعل الاصل في ذلك ما صرح به كاشف الغطاء قدس سره، بعد الحكم بأن كثير الشك لا إعتبار بشكه.
قال: (وكذا من خرج عن العادة في قطعه أو في ظنه فيلغو إعتبارهما في حقه) إنتهى.
أقول: أما عدم إعتبار ظن من خرج عن العادة في ظنه، فلان أدلة إعتبار الظن في مقام يعتبر فيه مختصة بالظن الحاصل من الاسباب التي يتعارف حصول الظن منها لمتعارف الناس لو وجدت تلك الاسباب عندهم على النحو الذي وجد عند هذا الشخص، فالحاصل من غيرها يساوي الشك في الحكم.
وأما قطع من خرج قطعه عن العادة: فإن أريد بعدم إعتباره عدم إعتباره في الاحكام التي يكون القطع موضوعا لها، كقبول شهادته وفتواه ونحو ذلك فهو حق، لان أدلة إعتبار العلم في هذه المقامات لا تشمل هذا قطعا، لكن ظاهر كلام من ذكره في سياق كثير الشك إرادة غير هذا القسم.
وإن أريد يه عدم إعتباره في مقامات يعتبر القطع فيها من حيث الكاشفية والطريقية إلى الواقع: فإن أريد بذلك أنه حين قطعه كالشاك، فلا شك في أن أحكام الشاك وغير العالم لا تجري في حقه.
وكيف يحكم على القاطع بالتكليف بالرجوع إلى ما دل على عدم الوجوب عند عدم العلم، والقاطع بأنه صلى ثلاثا بالبناء على أنه صلى أربعا، ونحو ذلك.
وإن أريد بذلك وجوب ردعه عن قطعه وتنزيله إلى الشك أو تنبيهه على مرضه ليرتدع بنفسه ولو بأن يقال له: (إن الله سبحانه لا يريد منك الواقع)، لو فرض عدم تفطنه، لقطعه بأن الله يريد
الواقع منه ومن كل احد، فهو حق.
لكنه يدخل في باب الارشاد، ولا يختص بالقطاع، بل بكل من قطع بما يقطع بخطائه فيه من الاحكام الشرعية والموضوعات الخارجية المتعلقة بحفظ النفوس والاعراض، بل الاموال في الجملة.
وأما في ما عدا ذلك مما يتعلق بحقوق الله سبحانه، فلا دليل على وجوب الردع في القطاع، كما لا دليل عليه في غيره.
ولو بنى على وجوب ذلك في حقوق الله سبحانه من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما هو ظاهر بعض النصوص والفتاوى، لم يفرق أيضا بين القطاع وغيره.
وإن أريد بذلك أنه بعد إنكشاف الواقع لا يجزي ما أتى به على طبق قطعه، فهو أيضا حق في الجملة، لان المكلف إن كان تكليفه حين العمل مجرد الواقع من دون مدخلية للاعتقاد، فالمأتي به المخالف للواقع لا يجزي عن الواقع، سواء القطاع وغيره.
وإن كان للاعتقاد مدخل فيه، كما في أمر الشارع بالصلاة إلى ما يعتقد كونها قبلة، فإن قضية هذا كفاية القطع المتعارف، لا قطع القطاع، فيجب عليه الاعادة وإن لم تجب على غيره.
ثم إن بعض المعاصرين وجه الحكم بعدم إعتبار قطع القطاع - بعد تقييده بما إذا علم القطاع أو احتمل أن يكون حجية قطعه مشروطة بعدم كونه قطاعا بأنه يشترط في حجية القطع عدم منع الشارع عنه وإن كان العقل أيضا قد يقطع بعدم المنع، إلا أنه إذا احتمل المنع يحكم بحجية القطع ظاهرا ما لم يثبت المنع.
وأنت خبير بأنه يكفي في فساد ذلك عدم تصور القطع بشئ عدم ترتيب آثار ذلك الشئ عليه مع فرض كون الآثار آثارا له.
والعجب أن المعاصر مثل لذلك بما إذا قال المولى لعبده: (لا تعتمد في معرفة أوامري على ما تقطع به من قبل عقلك أو يؤدي إليه حدسك، بل إقتصر على ما يصل إليك مني بطريق المشافهة والمراسلة).
وفساده يظهر مما سبق من أول المسألة إلى هنا.
الامرالرابع: إن المعلوم إجمالا هل هو كالمعلوم بالتفصيل في الاعتبار أم لا؟
والكلام فيه يقع تارة في إعتباره من حيث إثبات التكليف به وأن الحكم المعلوم بالاجمال هل هو كالمعلوم بالتفصيل في التنجز على المكلف أم هو كالمجهول رأسا.
وأخرى في أنه بعدما ثبت التكيلف بالعلم التفصيلي أو الاجمالي المعتبر فهل يكتفى في إمتثاله بالموافقة الاجمالية ولو مع تيسر العلم التفصيلي أم لا يكتفى به إلا مع تعذر العلم التفصيلي.
فلا يجوز إكرام شخصين أحدهما زيد مع التمكن من معرفة زيد بالتفصيل، ولا فعل الصلاتين في ثوبين مشتبهين مع إمكان الصلاة في ثوب طاهر.
والكلام من الجهة الاولى يقع من جهتين، لان إعتبار العلم الاجمالي له مرتبتان، الاولى حرمة المخالفة القطعية، والثانية وجوب الموافقة القطعية.
والمتكفل للتكلم في المرتبة الثانية هي مسألة البراءة والاشتغال عند الشك في المكلف به، فالمقصود في المقام الاول التكلم في المرتبة الاولى.
ولنقدم الكلام في:
المقام الثاني وهو كفاية العلم الاجمالي في الامتثال
فنقول: مقتضى القاعدة جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم الاجمالي بإتيان الملكف به.
أما فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الاطاعة ففي غاية الوضوح، وأما فيما يحتاج إلى قصد الاطاعة فالظاهر أيضا تحقق الاطاعة إذا قصد الاتيان بشيئين يقطع بكون أحدهما المأمور به.
ودعوى: (أن العلم بكون المأتي به مقربا معتبر حين الاتيان به ولا يكفي العلم بعده بإتيانه)، ممنوعة، إذ لا شاهد لها بعد تحقق الاطاعة بغير ذلك ايضا، فيجوز لمن تمكن من تحصيل العلم التفصيلي باداء العبادات العمل بالاحتياط وترك تحصيل العلم التفصيلي.
لكن الظاهر كما هو المحكي عن بعض ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقف على تكرار العبادة، بل ظاهر المحكي عن الحلي، في مسألة الصلاة في الثوبين، عدم جواز التكرار للاحتياط حتى مع عدم التمكن من العلم التفصيلي وإن كان ما ذكره من التعميم ممنوعا.
وحينئذ فلا يجوز لمن تمكن من تحصيل العلم بالماء المطلق أو بجهة القبلة أو في ثوب طاهر أن يتوضأ وضوئين يقطع بوقوع أحدهما بالماء المطلق أو يصلي إلى جهتين يقطع بكون أحدهما القبلة أو في ثوبين يقطع بطهارة أحدهما.
لكن الظاهر من صاحب المدارك، قدس سره، التأمل بل ترجيح الجواز في المسألة الاخيرة.
ولعله متأمل في الكل، إذ لا خصوصية لمسألة الاخيرة.
وأما إذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار، كما إذا أتي بالصلاة مع جميع ما يحتمل أن يكون جزءا، فالظاهر عدم ثبوت إتفاق على المنع ووجوب تحصيل اليقين التفصيلي.
لكن لا يبعد ذهاب المشهور إلى ذلك، بل ظاهر كلام السيد الرضي، رحمه الله، في مسألة الجاهل بوجوب القصر وظاهر تقرير أخيه السيد المرتضى، رحمه الله، له ثبوت الاجماع على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها.
هذا كله في تقديم العلم التفصيلي على الاجمالي.
وهل يلحق بالعلم التفصيلي الظن التفصيلي المعتبر، فيقدم على العلم الاجمالي ام لا؟ التحقيق أن يقال: إن الظن المذكور إن كان مما لم يثبت إعتباره إلا من جهة (دليل الانسداد) المعروف بين المتأخرين لاثبات حجية الظن المطلق، فلا إشكال في جواز ترك تحصيله والاخذ بالاحتياط إذا لم يتوقف على التكرار والعجب ممن يعمل بالامارات من باب الظن المطلق، ثم يذهب إلى عدم صحة عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد والاخذ بالاحتياط.
ولعل الشبهة من جهة إعتبار قصد الوجه.
ولابطال هذه الشبهة وإثبات صحة عبادة المحتاط محل آخر.
وأما لو توقف الاحتياط على التكرار، ففي جواز الاخذ به وترك تحصيل الظن بتعيين المكلف به أو عدم الجواز وجهان: من أ، العمل بالظن المطلق لم يثبت إلا جوازه وعدم وجوب تقديم الاحتياط عليه، أما تقديمه
على الاحتياط فلم يدل عليه دليل.
ومن أن الظاهر أن تكرار العبادة إحتياطا في الشبهة الحكمية مع ثبوت الطريق إلى الحكم الشرعي ولو كان الظن المطلق خلاف السيرة المستمرة بين العلماء، مع أن جواز العمل بالظن إجماعي، فيكفي في عدم جواز الاحتياط بالتكرار إحتمال عدم جوازه وإعتبار الاعتقاد التفصيلي في الامتثال.
والحاصل: أن الامر دائر بين تحصيل الاعتقاد التفصيلي ولو كان ظنا وبين تحصيل العلم بتحقق الاطاعة ولو إجمالا.
فمع قطع النظر عن الدليل الخارجي يكون الثاني مقدما على الاول في مقام الطاعة، بحكم العقل والعقلاء.
لكن بعد العلم بجواز الاول والشك في جواز الثاني في الشرعيات من جهة منع جماعة من الاصحاب عن ذلك وإطلاقهم إعتبار نية الوجه، فالاحوط ترك ذلك وإن لم يكن واجبا، لان نية الوجه لو قلنا بإعتباره فلا نسلمه إلا مع العلم بالوجه أو الظن الخاص، لا الظن المطلق الذي لم يثبت القائل به جوازه إلا بعدم وجوب الاحتياط لا بعدم جوازه، فكيف يعقل تقديمه على الاحتياط.
وأما لو كان الظن مما ثبت إعتباره بالخصوص، فالظاهر أن تقديمه على الاحتياط إذا لم يتوقف على التكرار مبني على إعتبار قصد الوجه.
وحيث قد رجحنا في مقامه عدم إعتبار نية الوجه فالاقوى جواز ترك تحصيل الظن والاخذ بالاحتياط.
ومن هنا يترجح القول بصحة عبادة المقلد إذا أخذ بالاحتياط وترك التقليد، إلا إنه خلاف الاحتياط من جهة وجود القول بالمنع من جماعة.
وإن توقف الاحتياط على التكرار فالظاهر أيضا جواز التكرار بل أولويته على الاخذ بالظن الخاص، ما تقدم من أن تحصيل الواقع بطريق العلم ولو إجمالا أولى من تحصيل الاعتقاد الظني به ولو كان تفصيلا.
وأدلة الظنون الخاصة إنما دلت على كفايتها عن الواقع، لا تعين العمل بها في مقام الامتثال.
إلا أن شبهة إعتبار نية الوجه، كما هو قول جماعة بل المشهور بين المتأخرين، جعل الاحتياط في خلاف ذلك، مضافا إلى ما عرفت من مخالفة التكرار للسيرة المستمرة.
مع إمكان أن يقال: إنه إذا شك بعد القطع بكون داعي الامر هو التعبد بالمأمور به.
لا حصوله بأي وجه إتفق، في أن الداعي هو التعبد بإيجاده ولو في ضمن أمرين أو أزيد، أو التعبد بخصوصه متميزا عن غيره، فالاصل عدم سقوط الغرض الداعي إلا بالثاني، وهذا ليس تقييدا في دليل تلك العبادة حتى يرفع بإطلاقه، كما لا يخفى.
وحينئذ فلا ينبغي بل لا يجوز ترك الاحتياط في جيمع موارد إرادة التكرار بتحصيل الواقع أولا
بظنه المعتبر من التقليد أو الاجتهاد بأعمال الظنون الخاصة أو المطلقة وإتيان الواجب مع نية الوجه، ثم الاتيان بالمحتمل الاخر بقصد القربة من جهة الاحتياط.
وتوهم: (أن هذا قد يخالف الاحتياط من جهة إحتمال كون الواجب ما أتي به بقصد القربة، فيكون قد أخل فيه بنية الوجوب)، مدفوع بأن هذا المقدار من المخالفة للاحتياط مما لا بد منه، إذ لو أتي به بنية الوجوب كان فاسدا قطعا، لعدم وجوبه ظاهرا على المكلف بعد فرض الاتيان بما وجب عليه في ظنه المعتبر.
وإن شئت قلت: إن نية الوجه ساقطة فيما يؤتى به من باب الاحتياط، إجماعا، حتى من القائلين بإعتبار نية الوجه، لان لازم قولهم بإعتبار نية الوجه في مقام الاحتياط عدم مشروعية الاحتياط وكونه لغوا.
ولا أظن أحدا يلتزم بذلك، عدى السيد أبي المكارم في ظاهر كلامه في الغنية في رد الاستدلال على كون الامر للوجوب بأنه أحوط، وسيأتي ذكره عند الكلام على الاحتياط في طي مقدمات دليل الانسداد.
اما المقام الاول وهو كفاية العلم الاجمالي في تنجز التكليف وإعتباره كالتفصيلي
فقد عرفت أن الكلام في إعتباره بمعنى وجوب الموافقة القطعية وعدم كفاية الموافقة الاحتمالية راجع إلى مسألة البراءة والاحتياط.
والمقصود هنا بيان إعتباره في الجملة الذي أقل مراتبه حرمة المخالفة القطعيه، فنقول: إن للعلم الاجمالي صورا كثيرة، لان الاجمال الطاري، إما من جهة متعلق الحكم مع تبين نفس الحكم تفصيلا، كما لو شككنا أن حكم الوجوب في يوم الجمعة يتعلق الظهر أو الجمعة، و حكم الحرمة يتعلق بهذا الموضوع الخارجي من المشتبهين أو بذاك، وإما من جهة نفس الحكم مع تبين موضوعه، كما لو شك في أن هذا الموضوع المعلوم الكلي أو الجزئي يتعلق به الوجوب أو الحرمة، وإما من جهة الحكم والمتعلق جميعا، مثل أن نعلم أن حكما من الوجوب والتحريم تعلق بأحد هذين الموضوعين.
ثم الاشتباه في كل من الثلاثة، إما من جهة الاشتباه في الخطاب الصادر من الشارع كما في مثال الظهر والجمعة، وإما من جهة إشتباه مصاديق متعلق ذلك الخطاب كما في المثال الثاني.
والاشتباه في هذا القسم إما في المكلف به كما في الشبهة المحصورة وإما في المكلف.
وطرفا الشبهة في المكلف إما أن يكونا إحتمالين في مخاطب واحد كما في الخنثى، وإما أن يكونا إحتمالين في مخاطبين كما في واجدي المني في الثوب المشترك.
ولا بد قبل التعرض لبيان حكم الاقسام من التعرض لامرين.
أحدهما: إنك قد عرفت في أول مسألة إعتبار العلم أن إعتباره قد يكون من باب محض الكشف والطريقية وقد يكون من باب الموضوعية بجعل الشارع.
والكلام هنا في الاول، إذ إعتبار العلم الاجمالي وعدمه في الثاني تابع لدلالة ما دل على جعله موضوعا.
فإن دل على كون العلم التفصيلي داخلا في الموضوع، كما لو فرضنا أن الشارع لم يحكم بوجوب الاجتناب إلا عما علم تفصيلا نجاسته، فلا إشكال في عدم إعتبار العلم الاجمالي بالنجاسة.
الثاني: أنه إذا تولد من العلم الاجمالي العلم التفصيلي بالحكم الشرعى في مورد، وجب إتباعه وحرم مخالفته، لما تقدم من إعتبار العلم التفصيلي من غير تقييد بحصوله من منشأ خاص.
فلا فرق بين من علم تفصيلا ببطلان صلاته بالحدث أو بواحد مردد بين الحدث والاستدبار، أو بين ترك ركن وفعل مبطل، أو بين فقد شرط من شرائط صلاة نفسه وفقد شرط من شرائط صلاة إمامه بناء على إعتبار وجود شرائط الامام في علم المأموم، إلى غير ذلك.
وبالجملة فلا فرق بين هذا العلم التفصيلي وبين غيره من العلوم التفصيلية.
إلا أنه قد ورد في الشرع مواورد توهم خلاف ذلك.
منها: ما حكم به بعض فيما إذا إختلفت الامة على قولين ولم يكن مع أحدهما دليل، من أن يطرح القولان ويرجع إلى مقتضى الاصل، فإن إطلاقه يشمل ما لو علمنا بمخالفة مقتضى الاصل للحكم الواقعي المعلوم وجوده بين القولين، بل ظاهر كلام الشيخ، رحمه الله، القائل بالتخيير هو التخيير الواقعي المعلوم تفصيلا مخالفته لحكم الله الواقعي في الواقعة.
ومنها: حكم بعض بجواز إرتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة دفعة أو تدريجا، فإنه قد يؤدي إلى العلم التفصيلي بالحرمة أو النجاسة.كما لو إشترى بالمشتبهين بالميتة جارية.
فإنا نعلم تفصيلا بطلان البيع في تمام الجارية لكون بعض ثمنها ميتة، فنعلم تفصيلا بحرمة وطيها، مع أن القائل بجواز الارتكاب لم يظهر من كلامه إخراج هذه الصور.
ومنها: حكم بعض بصحة إئتمام أحد واجدي المنيي في الثوب المشترك بينهما بالاخر مع أن
المأموم يعلم تفصيلا ببطلان صلاته من جهة حدثه أو حدث إمامه.
ومنها: حكم الحاكم بتنصيف العين التي تداعاها رجلان بحيث يعلم صدق أحدهما وكذب الاخر، فإن لازم ذلك جواز شراء ثالث للنصفين من كل منهما مع أنه يعلم تفصيلا عدم إنتقال تمام المال إليه من مالكه الواقعي.
ومنها: حكمهم بأنه لو كان لاحد درهم ولاخر درهمان، فتلف أحد الدراهم من عند الودعي، أن لصاحب الاثنين واحدا ونصفا وللاخر نصفا، فإنه قد يتفق إفضاء ذلك إلى مخالفة تفصيليلة.
كما لو أخذ الدرهم المشترك بينهما ثالث، فإنه يعلم تفصيلا بعدم إنتقاله من مالكه الواقعي إليه.
ومنها: ما لو أقر بعين لشخص ثم أقر بها لآخر، فإنه يغرم للثاني قيمة العين بعد دفعها إلى الاول، فإنه قد يؤدي ذلك إلى إجتماع العين والقيمة عند واحد وبيعهما بثمن واحد، فيعلم عدم إنتقال تمام الثمن إليه، لكون بعض مثمنه مال المقر في الواقع.
ومنها: الحكم بإنفساخ العقد المتنازع في تعيين ثمنه أو مثمنه على وجه يقضى فيه بالتحالف.
كما لو إختلفا في كون المبيع بالثمن المعين عبدا أو جارية، فإن رد الثمن إلى المشتري بعد التحالف مخالف للعلم التفصيلي بصيرورته ملك البائع ثمنا للعبد أو الجارية، وكذا لو إختلفا في كون ثمن الجارية المعينة عشرة دنانير أو مائة درهم، فإن الحكم برد الجارية مخالف للعلم التفصيلي بدخولها في ملك المشتري.
ومنها: حكم بعضهم بأنه لو قال أحدهما: بعتك الجارية بمائة، وقال الآخر: وهبتني إياها بأنهما يتحالفان وترد الجارية إلى صاحبها، مع أنا نعلم تفصيلا بإنتقالها من ملك صاحبها إلى الاخر.
إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع.
فلا بد في هذه الموارد من إلتزام أحد أمور على سبيل منع الخلو: أحدها: كون العلم التفصيلي في كل من أطراف الشبهة موضوعا للحكم.
بأن يقال: الواجب الاجتناب عما علم كونه بالخصوص بولا، فالمشتبهان طاهران في الواقع.
وكذا المانع للصلاة الحدث المعلوم صدوره تفصيلا من مكلف خاص، فالمأموم والامام متطهران في الواقع.
الثاني: أن الحكم الظاهري في حق كل أحد نافذ واقعا في حق الاخر، بأن يقال: إن من كانت صلاته بحسب الظاهر صحيحة عند نفسه، فللاخر أن يترتب عليها آثار الصحة الواقعية فيجوز له الائتمام، وكذا من حل له أخذ الدار، ممن وصل إلى نصفه إذا لم يعلم كذبه في الدعوى بأن إستند إلى بينة أو إقرار أو إعتقاد من القرائن، فإنه يملك هذا النصف في الواقع.وكذلك إذا إشترى
النصف الاخر فيثبت ملكه للنصفين في الواقع.وكذا الاخذ ممن وصل إليه نصف الدرهم في مسألة الصلح وفي مسألتي التحالف.
الثالث: أن يلتزم بتقييد الاحكام المذكورة بما إذا لم يفض إلى العلم التفصيلي بالمخالفة والمنع مما يستلزم المخالفة تفصيلا، كمسألة إختلاف الامة على قولين وحمل أخذ المبيع في مسألتي التحالف على كونه تقاصا شرعيا قهريا عما يدعيه من الثمن أو إنفساخ البيع بالتحالف من أصله أو من حينه وكون أخذ نصف الدرهم مصالحة قهرية.
وعليك بالتأمل في دفع الاشكال عن كل مورد بأحد الامور المذكورة، فإن إعتبار العلم التفصيلي بالحكم الواقعي وحرمة مخالفته مما لا يقبل التخصيص بإجماع أو نحوه.
* * *
إذا عرفت هذا فلنعد إلى حكم مخالفة العلم الاجمالي، فنقول: مخالفة الحكم المعلوم بالاجمال يتصور على وجهين.
أحدهما: مخالفته من حيث الالتزام، كالالتزام بإباحة وطي المرأة المرددة بين من حرم وطيها بالحلف ومن وجب وطيها به مع إتحاد زماني الوجوب والحرمة، وكالالتزام بإباحة موضوع كلي مردد أمره بين الوجوب والتحريم مع عدم كون أحدهما المعين تعبديا يعتبر فيه قصد الامتثال، فإن المخالفة في المثالين ليس من حيث العمل، لانه لا يخلو من الفعل الموافق للوجوب أو الترك الموافق للحرمة.فلا قطع بالمخالفة إلا من حيث الالتزام بإباحة الفعل.
الثاني: مخالفته من حيث العمل، كترك الامرين اللذين يعلم بوجوب أحدهما، وإرتكاب فعلين يعلم بحرمة أحدهما، فإن المخالفة هنا من حيث العمل.
وبعد ذلك فنقول: أما المخالفة الغير العملية، فالظاهر جوازها في الشبهة الموضوعية والحكمية معا، سواء كان الاشتباه والترديد بين حكمين لموضوع واحد كالمثالين المتقدمين، أو بين حكمين لموضوعين كطهارة البدن وبقاء الحدث لمن توضأ غفلة بمائع مردد بين الماء والبول.
أما في الشبهة الموضوعية، فلان الاصل فيها إنما يخرج مجراه عن موضوع التكليفين، فيقال: الاصل عدم تعلق الحلف بوطي هذه وعدم تعلق الحلف بترك وطيها، فتخرج المرأة بذلك عن موضوع حكمي التحريم والوجوب، فيحكم بالاباحة لاجل الخروج من موضوع الوجوب والحرمة، لا لاجل طرحهما.
وكذا الكلام في الحكم بطهارة البدن وبقاء الحدث في الوضوء بالمائع المردد.
وأما الشبهة الحكمية، فلان الاصول الجارية فيها وإن لم يخرج مجراها عن موضوع الحكم
الواقعي، بل كانت منافية لنفس الحكم، كأصالة الاباحة مع العلم بالوجوب أو الحرمة، فإن الاصول في هذه منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم إجمالا، لا مخرجة عن موضوعة، إلا أن الحكم الواقعي المعلوم إجمالا لا يترتب عليه أثر إلا وجوب الاطاعة وحرمة المعصية والمفروض أنه لا يلزم من إعمال الاصول مخالفة عملية له ليتحقق المعصية، ووجوب الالتزام بالحكم الواقعي مع قطع النظر عن العمل غير ثابت.
لان الالتزام بالاحكام الفرعية إنما يجب مقدمة للعمل وليست كالاصول الاعتقادية يطلب فيها الالتزام والاعتقاد من حيث الذات.
ولو فرض ثبوت الدليل عقلا أو نقلا على وجوب الالتزام بحكم الله الواقعي لم ينفع، لان الاصول تحكم في مجاريها بإنتفاء الحكم الواقعي، فهي كالاصول في الشبهة الموضوعية مخرجة لمجاريها عن موضوع ذلك الحكم، أعني وجوب الاخذ بحكم الله، هذا.
ولكن التحقيق أنه لو ثبت هذا التكليف، أعني وجوب الاخذ بحكم الله والالتزام مع قطع النظر عن العمل، لم تجر الاصول، لكونها موجبة للمخالفة العملية للخطاب التفصيلي، أعني وجوب الالتزام بحكم الله، وهو غير جائز حتى في الشبهة الموضوعية، كما سيجئ، فيخرج عن المخالفة الغير العملية.
فالحق - مع فرض عدم قيام الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع على ما جاء به - أن طرح الحكم الواقعي ولو كان معلوما تفصيلا ليس محرما إلا من حيث كونها معصية دل العقل على قبحها وإستحقاق العقاب بها.
فإذا فرض العلم تفصيلا بوجوب الشئ فلم يلتزم به المكلف إلا أنه فعله لا لداعي الوجوب، لم يكن عليه شئ.
نعم لو أخذ في ذلك الفعل نية القربة فالاتيان به لا للوجوب مخالفة عملية و معصية لترك المأمور به.
ولذا قيدنا الوجوب والتحريم في صدر المسألة بغير ما علم كون أحدهما المعين تعبديا.
فإذا كان هذا حال العلم التفصيلي، فإذا علم إجمالا بحكم مردد بين الحكمين وفرضنا إجراء الاصل في نفي الحكمين اللذين علم بكون أحدهما حكم الشارع، والمفروض أيضا عدم مخالفتهما في العمل، فلا معصية ولا قبح، بل وكذلك لو فرضنا عدم جريان الاصل، لما عرفت من ثبوت ذلك في العلم التفصيلي.
فملخص الكلم أن المخالفة من حيث الالتزام ليست مخالفة، ومخالفة الاحكام الفرعية إنما هي في العمل، ولا عبرة بالالتزام وعدمه.
ويمكن أن يقرر دليل الجواز أى جواز المخالفة فيه بوجه أخصر: وهو أنه لو وجب الالتزام: فإن كان بأحدهما المعين واقعا فهو تكليف من غير بيان ولا يلتزمه أحد، وإن كان بأحدهما على وجه التخيير فهذا لا يمكن أن يثبت بذلك الخطاب الواقعي المجمل، فلا بد له من خطاب آخر.
وهو، مع أنه لا دليل عليه، غير معقول، لان الغرض من هذا الخطاب المفروض كونه توصليا حصول مضمونه، أعني إيقاع الفعل أو الترك تخييرا، وهو حاصل من دون الخطاب التخييري، فيكون الخطاب طلبا للحاصل، وهو محال.
إلا أن يقال: إن المدعي للخطاب التخييري إنما يدعي ثبوته بأن يقصد منه التعبد بأحد الحكمين، لا مجرد حصول مضمون أحد الخطابين الذي هو حاصل، فينحصر دفعه حينئذ بعدم الدليل، فافهم، هذا.
وأما دليل وجوب الالتزام بما جاء به النبي، صلى الله عليه وآله، فلا يثبت إلا الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه، لا الالتزام بأحدهما تخييرا عند الشك، فافهم، هذا.
ولكن الظاهر من جماعة من الاصحاب، في مسألة الاجماع المركب، إطلاق القول بالمنع عن الرجوع إلى حكم علم عدم كونه حكم الامام في الواقع.وعليه بنوا.عدم جواز الفصل فيما علم كون الفصل فيه طرحا لقول الامام عليه السلام.
نعم صرح غير واحد من المعاصرين، في تلك المسألة فيما إذا إقتضى الاصلان حكمين يعلم بمخالفة أحدهما للواقع، بجواز العمل بكليهما.وقاسه بعضهم على العمل بالاصلين المتنافيين في الموضوعات.
لكن القياس في غير محله، لما تقدم من أن الاصول في الموضوعات حاكمة على أدلة التكليف، فإن البناء على عدم تحريم المرأة لاجل البناء بحكم الاصل على عدم تعلق الحلف بترك وطيها، فهي خارجة عن موضوع الحكم بتحريم وطي من حلف على ترك وطيها.
وكذا الحكم بعدم وجوب وطيها لاجل البناء على عدم الحلف على وطيها، فهي خارجة عن موضوع الحكم بوجوب وطي من حلف على وطيها وهذا بخلاف الشبهة الحكمية، فإن الاصل فيها معارض لنفس الحكم المعلوم بالاجمال وليس مخرجا لمجراه عن موضوعه حتى لا ينافيه جعل الشارع.
لكن هذا المقدار من الفرق غير مجد، إذ اللازم من منافاة الاصول لنفس الحكم الواقعي، حتى مع العلم التفصيلي ومعارضتها له، هو كون العمل بالاصول موجبا لطرح الحكم الواقعي من حيث الالتزام.
فإذا فرض جواز ذلك، لان العقل والنقل لم يدلا إلا على حرمة المخالفة العملية، فليس
الطرح من حيث الالتزام مانعا عن إجراء الاصول المتنافية في الواقع.
ولا يبعد حمل إطلاق كلمات العلماء في عدم جواز طرح قول الامام، عليه السلام، في مسألة الاجماع على طرحه من حيث العمل، إذ هو المسلم المعروف من طرح قول الحجة.
فراجع كلماتهم فيما إذا إختلفت الامة على قولين ولم يكن مع أحدهما دليل، فإن ظاهرالشيخ، رحمه الله، الحكم بالتخيير الواقعى وظاهر المنقول عن بعض طرحهما والرجوع إلى الاصل.
ولا ريب أن في كليهما طرحا للحكم الواقعي، لان التخيير الواقعي كالاصل حكم ثالث.
نعم ظاهرهم في مسألة دوران الامر بين الوجوب والتحريم الاتفاق على عدم الرجوع إلى الاباحة وإن إختلفوا بين قائل بالتخيير وقائل بتعيين الاخذا بالحرمة.
والانصاف: أنه لا يخلو عن قوة، لان المخالفة العملية التي لا تلزم في المقام هي المخالفة دفعة وفي واقعة عن قصد وعمد، وأما المخالفة تدريجا وفي واقعتين فهي لازمة البتة.
والعقل كما يحكم بقبح المخالفة دفعة عن قصد وعمد، كذلك يحكم بحرمة المخالفة في واقعتين تدريجا عن قصد إليهما من غير تقييد بحكم ظاهري عند كل واقعة.وحينئذ فيجب بحكم العقل الالتزام بالفعل أو الترك.
إذ في عدمه إرتكاب لما هو مبغوض للشارع يقينا عن قصد.
وتعدد الواقعة إنما يجدي مع الاذن من الشارع عند كل واقعة.
كما في تخيير الشارع للمقلد بين قولي مجتهدين تخييرا مستمرا يجوز معه الرجوع عن احدهما إلى الاخر.
وأما مع عدمه فالقادم على ما هو مبغوض للشارع يستحق عقلا العقاب على إرتكاب ذلك المبغوض.
أما لو إلتزم بأحذ الاحتمالين قبح عقابه على مخالفة الواقع لو إتفقت.
ويمكن إستفادة الحكم أيضا من فحوى أخبار التخيير عند التعارض، لكن هذا الكلام لا يجري في الشبهة الواحدة التي لم تتعدد فيها الواقعة حتى تحصل المخالفة العملية تدريجا.
فالمانع في الحقيقة هي المخالفة العملية القطعية ولو تدريجا مع عدم التعبد بدليل ظاهري، فتأمل جدا.
هذا كله في المخالفة القطعية للحكم المعلوم إجمالا من حيث الالتزام، بأن لا يلتزم به أو يلتزم بعدمه في مرحلة الظاهر إذا إقتضت الاصول ذلك.
وأما المخالفة العملية، فإن كانت لخطاب تفصيلي، فالظاهر عدم جوازها، سواء كانت في الشبهة الموضوعية، كإرتكاب الانائين المشتبهين المخالف لقول الشارع: (إجتنب عن النجس)، أو كترك القصر والاتمام في موارد إشتباه الحكم، لان ذلك معصية لذلك الخطاب.
لان المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بين الانائين، ووجوب صلاة الظهر والعصر، مثلا، قصرا أو
إتماما.
وكذا لو قال: (أكرم زيدا)، واشتبه بين شخصين، فإن ترك إكرامهما معصية.
فإن قلت: إذا أجرينا أصالة الطهارة في كل من الانائين وأخرجناهما عن موضوع النجس بحكم الشارع فليس في إرتكابهما، بناء على طهارة كل منهما، مخالفة لقول الشارع: (إجتنب عن النجس).
قلت: أصالة الطهارة في كل مهما بالخصوص إنما يوجب جواز إرتكابه من حيث هو.
وأما الاناء النجس الموجود بينهما فلا أصل يدل على طهارته، لانه نجس يقينا، فلا بد إما من إجتنابهما تحصيلا للموافقة القطعية، وإما أن يجتنب أحدهما فرارا عن المخالفة القطعية على الاختلاف المذكور في محله.
هذا، مع أن حكم الشارع بخروج مجرى الاصل عن موضوع المكلف به الثابت بالادلة الاجتهادية لا معنى له إلا رفع حكم ذلك الموضوع، فمرجع أصالة الطهارة إلى عدم وجوب الاجتناب المخالف لقوله: (إجتنب عن النجس)، فافهم.
وإن كانت المخالفة مخالفة لخطاب مردد بين خطابين كما إذا علمنا بنجاسة هذا المائع أو بحرمة هذه المرأة، أو علمنا بوجوب الدعاء عند رؤية هلال رمضاه، أو بوجوب الصلاة عند ذكر النبي، صلى الله عليه وآله ففي المخالفة القطعية حنيئذ وجوه:
أحدهما: الجواز مطلقا، لان المردد بين الخمر والاجنبية لم يقع النهي عنه في خطاب من الخطابات الشرعية حتى يحرم إرتكابه، وكذا المردد بين الدعاء والصلاة، فإن الاطاعة والمعصية عبارة عن موافقة الخطابات التفصيلية ومخالفتها.
الثاني: عدم الجواز مطلقا، لان مخالفة الشارع قبيحة عقلا مستحقة للذم عليها، ولا يعذر فيها إلا الجاهل بها.
الثالث: الفرق بين الشبهة في الموضوع والشبهة في الحكم، فيجوز في الاولى دون الثانية، لان المخالفة القطعية في الشبهات الموضوعية فوق حد الاحصاء، بخلاف الشبهات الحكمية، كما يظهر من كلماتهم في مسائل الاجماع المركب.
وكان الوجه ما تقدم، من أن الاصول في الموضوعات تخرج مجاريها عن موضوعات أدلة التكليف.
بخلاف الاصول في الشبهات الحكمية، فإنها منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم إجمالا.
وقد عرفت ضعف ذلك، وأن مرجع الاخراج الموضوعي إلى رفع الحكم المترتب على ذلك، فيكون الاصل في الموضوع في الحقيقة منافيا لنفس الدليل الواقعي إلا أنه حاكم عليه لا معارض له، فافهم.
الرابع: الفرق بين كون الحكم المشتبه في موضوعين واحدا بالنوع كوجوب أحدالشيئين وبين
إختلافه كوجوب الشئ وحمرمة آخر.
والوجه في ذلك أن الخطابات في الواجبات الشرعية بأسرها في حكم خطاب واحد بفعل الكل، فترك البعض معصية عرفا، كما لو قال المولى: (إفعل كذا وكذا وكذا)، فإنه بمنزلة: (إفعلها جميعا)، فلا فرق في العصيان بين ترك واحد منها معينا أو واحد غير معين عنده.
نعم في وجوب الموافقة القطعية بالاتيان بكل واحد من المحتملين كلام آخر مبني على أن مجرد العلم بالحكم الواقعي يقتضي البرآة اليقينية العلمية عنه أو يكتفي بأحدهما حذرا عن المخالفة القطعية التي هي نفسها مذمومة عند العقلاء ويعد معصية عندهم وإن لم يلتزموا الامتثال اليقيني لخطاب مجمل.
والاقوى من هذه الوجوه هو الوجه الثاني ثم الاول ثم الثالث ثم الرابع.
هذا كله في إشتباه الحكم من حيث الفعل المكلف به.
* * *
وأما الكلام في إشتباهه من حيث المكلف بذلك الحكم، فقد عرفت أنه يقع تارة في الحكم الثابت لموضوع واقعي مردد بين شخصين، كأحكام الجنابة المتعلقة بالجنب المردد بين واجدي المني، وقد يقع في الحكم الثابت لشخص من جهة تردده بين موضوعين، كحكم الخنثى المردد بين الذكر والانثى.
أما الكلام في الاول: فمحلصه: أن مجرد التكليف بين شخصين لا يوجب على أحدهما شيئا، إذ العبرة في الاطاعة والمعصية بتعلق الخطاب بالمكلف الخاص، فالجنب المردد بين شخصين غير مكلف بالغسل وإن ورد من الشارع أنه يجب الغسل على كل جنب، فإن كلا منهما شاك في توجه هذا الخطاب إليه، فيقبح عقاب واحد من الشخصين يكون جنبا بمجرد هذا الخطاب الغير الموجه إليه.
نعم لو إتفق لاحدهما أو لثالث علم بتوجه الخطاب إليه دخل في إشتباه متعلق التكليف الذي تقدم حكمه باقسامه.
ولا بأس بالاشارة إلى بعض فروع المسأله، ليتضح إنطباقها على ما تقدم في العلم الاجمالي بالتكليف.
فمنها: حمل احدهما الاخر وإدخاله في المسجد للطواف أو لغيره، بناء على تحريم إدخال الجنب او إدخال النجاسة الغير المتعدية.
فإن قلنا إن الدخول والادخال متحققان بحركة واحدة، دخل في المخالفة المعلومة تفصيلا وإن تردد بين كونه من جهة الدخول أو الادخال.
وإن جعلناهما متغايرين في الخارج كما في الذهن: فإن جعلنا الدخول والادخال راجعين إلى عنوان محرم واحد، وهو القدر المشترك بين إدخال النفس وإدخال الغير، كان من المخالفة المعلومة للخطاب التفصيلي، نظير إرتكاب المشتبهين بالنجس.
وإن جعلنا كلا منهما عنوانا مستقلا دخل في المخالفة للخطاب المعلوم بالاجمال الذي عرفت فيه الوجوه المتقدمة، وكذا من جهة دخول المحمول وإستيجاره الحامل مع قطع النظر عن حرمة الدخول والادخال عليه أو فرض عدمها حيث أنه علم إجمالا بصدور أحد المحرمين إما دخول المسجد جنبا او استجار جنب للدخول في المسجد.
إلا ان يقال بأن الاستيجار تابع لحكم الاجير، فاذا لم يكن هو في تكليفه محكوما بالجنابة وابيح له الدخول في المسجد صح استيجار الغير له.
ومنها: إقتداء الغير بهما في صلاة أو صلاتين.
فإن قلنا بأن عدم جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعية، كان الاقتداء بهما في صلاة واحدة موجبا للعلم التفصيلي ببطلان الصلاة والاقتداء بهما في صلاتين من قبيل إرتكاب الانائين والاقتداء بأحدهما في صلاة واحدة كإرتكاب أحد الانائين.
وإن قلنا إنه يكفي في جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص في حكم نفسه، صح الاقتداء في صلاة، فضلا عن صلاتين، لانهما طاهران بالنسبة إلى حكم الاقتداء.والاقوى هو الاول، لان الحدث مانع واقعي لا علمي.
نعم لا إشكال في إستيجارهما لكنس المسجد، فضلا عن إستيجار أحدهما، لان صحة الاستيجار تابعة لاباحة الدخول لهما، لا للطهارة الواقعية، والمفروض إباحته لهما.
وقس على ما ذكرنا جميع ما يرد عليك مميزا بين الاحكام المتعلقة بالجنب من حيث الحدث الواقعي وبين الاحكام المتعلقة بالجنب من حيث أنه مانع ظاهري للشخص المتصف به.
وأما الكلام في الخنثى: فيع تارة في معاملتها مع غيرها من معلوم الذكورية والانوثية أو مجهولهما، وحكمهما بالنسبة إلى التكاليف المختصة بكل من الفريقين، وتارة في معاملة الغير معهما، وحكم الكل يرجع إلى ما ذكرنا في الاشتباه المتعلق بالمكلف به.
أما معاملتها مع الغير، فمقتضى القاعدة إحترازها عن غيرها مطلقا، للعلم الاجمالي بحرمة نظرها
إلى إحدى الطائفتين، فتجتنب عنهما مقدمة.
وقد يتوهم: (أن ذلك من باب الخطاب الاجمالي، لان الذكور مخاطبون بالغض عن الاناث وبالعكس، والخنثى شاك في دخوله في أحد الخطابين).
والتحقيق هو الاول، لانه علم تفصيلا بتكليفه بالغص عن إحدى الطائفتين، ومع العلم التفصيلي لا عبرة بإجمال الخطاب كما تقدم في الدخول والادخال في المسجد لواجدي المني مع أنه يمكن إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد، وهو تحريم نظر كل إنسان إلى كل بالغ لا يماثله في الذكورية والانوثية عدا من يحرم نكاحه.
ولكن يمكن أن يقال: إن الكف عن النظر إلى ما عدى مشقة عظيمة فلا يجب الاحتياط فيه، بل العسر فيه أولى من الشبهة الغير المحصورة، أو يقال: إن رجوع الخطابين إلى خطاب واحد في حرمة المخالفة القطعية، لا في وجوب الموافقة القطعية، فافهم.
وهكذا حكم لباس الخنثى، حيث إنه يعلم إجمالا بحرمة واحد من مختصات الرجال كالمنطقة والعمامة أو مختصات النساء عليه، فيجتنب عنهما.
وأما حكم ستارته في الصلاة، فيجتنب الحرير ويستر جميع بدنه.
وأما حكم الجهر والاخفات، فإن قلنا بكون الاخفات في العشائين والصبح رخصة للمرأة جهر الخنثى بهما، وإن قلنا إنه عزيمة لها فالتخيير، إن قام الاجماع على عدم وجوب تكرار الصلاة في حقها.
وقد يقال بالتخيير مطلقا، من جهة ما ورد: من أن الجاهل في الجهر والاخفات معذور.
وفيه مضافا إلى أن النص إنما دل على معذورية الجاهل بالنسبة إلى لزوم الاعادة لو خالف الواقع، وأين هذا من تخيير الجاهل من أول الامر بينهما، بل الجاهل لو جهر أو أخفت مترددا بطلت صلاته، إذ يجب عليه الرجوع إلى العلم أو العالم -: أن الظاهر من الجهل في الاخبار غير هذا الجهل.
وأما تخيير قاضي الفريضة المنسية عن الخمس في ثلاثية ورباعية وثنائية، فإنما هو بعد ورود النص في الاكتفاء بالثلاث المستلزم لالغاء الجهر والاخفات بالنسبة إليه، فلا دلالة فيه على تخيير الجاهل بالموضوع مطلقا.
وأما معاملة الغير معها، فقد يقال بجواز نظر كل من الرجل والمرأة إليها، لكونها شبهة في الموضوع، والاصل الاباحة.
وفيه: أن عموم وجوب الغض على المؤمنات، إلا عن نسائهن أو الرجال المذكورين في الاية، يدل على وجوب الغض عن الخنثى.ولذا حكم في جامع المقاصد بتحريم نظر الطائفتين
إليها، كتحريم نظرها إليهما.
بل إدعى سبطه الاتفاق على ذلك، فتأمل جدا.
ثم إن جميع ما ذكرنا إنما هو في غير النكاح.
وأما التناحك، فيحرم بينه وبين غيره قطعا، فلا يجوز له تزويج إمرأة، لاصالة عدم ذكوريته بمعنى عدم ترتب أثر الذكورية من جهة النكاح و وجوب حفظ الفرج إلا عن الزوجة وملك اليمين - ولا التزوج برجل، لاصالة عدم كونه إمرأة، كما صرح به الشهيد.
لكن ذكر الشيخ مسألة فرض الوارث الخنثى المشكل زوجا أو زوجة، فافهم.
هذا تمام الكلام في إعتبار العلم.
المقصد الثاني في الظن ...المقام الاول: إمكان التعبد بالظن عقلا
أما الاول، فاعلم أن المعروف هو إمكانه.
ويظهر من الدليل المحكي عن إبن قبة، في إستحالة العمل بالخبر الواحد، عموم المنع لمطلق الظن، فإنه إستدل على مذهبه بوجهين:
(الاول: أنه لو جاز التعبد بخبر الواحد في الاخبار عن النبي، صلى الله عليه وآله، لجاز التعبد به في الاخبار عن الله تعالى، والتالي باطل إجماعا.
الثاني: أن العمل به موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال، إذ لا يؤمن أن يكون ما أخبر بحليته حراما وبالعكس).
وهذا الوجه - كما ترى - جار في مطلق الظن، بل في مطلق الامارة الغير العلمية وإن لم يفد الظن.
وإستدل المشهور على الامكان: بأنا نقطع بأنه لا يلزم من التعبد به محال.
وفي هذا التقرير نظر، إذ القطع بعدم لزوم المحال موقوف على إحاطة العقل جميع الجهات المحسنة والمقبحة وعلمه بإنتفائها، وهو غير حاصل فيما نحن فيه.
فالاولى أن يقرر هكذا: إنا لا نجد في عقولنا بعد التأمل ما يوجب الاستحالة، وهذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالامكان.
والجواب عن دليله الاول: أن الاجماع إنما قام على عدم الوقوع، لا على الامتناع، مع أن عدم الجواز قياسا على الاخبار عن الله تعالى، بعد تسليم صحة الملازمة، إنما هو فيما إذا بني تأسيس الشريعة أصولا وفروعا على العمل بخبر الواحد، لا مثل ما نحن فيه، مما ثبت أصل الدين وجميع فروعه بالادلة القطعية، لكن عرض إختفاؤها في الجملة من جهة العوارض وإخفاء الظالمين للحق.
وأما دليله الثاني: فقد أجيب عنه تارة بالنقض بالامور الكثيرة الغير المفيدة للعلم، كالفتوى والبينة واليد، بل القطع أيضا، لانه قد يكون جهلا مركبا.وأخرى بالحل بأنه إن أريد تحريم
الحلال الظاهري أو عكسه فلا نسلم لزومه، وإن أريد تحريم الحلال الواقعي ظاهرا فلا نسلم إمتناعه.
والاولى أن يقال: إنه إن أراد إمتناع التعبد بالخبر في المسألة التي إنسد فيها باب العلم بالواقع، فلا يعقل المنع عن العمل به فضلا عن إمتناعه.
إذ من فرض عدم التمكن مع العلم بالواقع، إما أن يكون للمكلف حكم في تلك الواقعة، وإما أن لا يكون له فيها حكم، كالبهائم والمجانين.
فعلى الاول، فلا مناص عن إرجاعه إلى ما لا يفيد العلم من الاصول والامارات الظنية التي منها الخبر الواحد.
وعلى الثاني يلزم ترخيص فعل الحرام الواقعي وترك الواجب الواقعي، وقد فر المستدل منهما.
فإن التزم أن مع عدم التمكن من العلم لا وجوب ولا تحريم، لان الواجب والحرام ما علم بطلب فعله أو تركه.
قلنا: فلا يلزم من التعبد بالخبر تحليل حرام أو عكسه.
وكيف كان فلا نظن بالمستدل إرادة الامتناع في هذا الفرض، بل الظاهر أنه يدعي الانفتاح، لانه أسبق من السيد وأتباعه الذين إدعوا إنفتاح باب العلم.
ومما ذكرنا: ظهر أنه لا مجال للنقض عليه بمثل الفتوى، لان المفروض إنسداد باب العلم على المستفتي.
وليس له شئ أبعد من تحريم الحلال وتحليل الحرام من العمل بقول المفتي، حتى أنه لو تمكن من الظن الاجتهادي فالاكثر على عدم جواز العمل بفتوى الغير.
وكذلك نقضه بالقطع مع إحتمال كونه في الواقع جهلا مركبا، فإن باب هذا الاحتمال منسد على القاطع.
وإن أراد الامتناع مع إنفتاح باب العلم والتمكن منه في مورد العمل بالخبر، فنقول: إن التعبد بالخبر حينئذ يتصور على وجهين:
أحدهما: أن يجب العمل به، لمجرد كونه طريقا إلى الواقع وكاشفا ظنيا عنه، بحيث لم يلاحظ فيه مصلحة سوى الكشف عن الواقع، كما قد يتفق ذلك عند إنسداد باب العلم وتعلق الغرض بإصابة الواقع، فإن الامر بالعمل بالظن الخبري أو غيره لا يحتاج إلى مصلحة سوى كونه كاشفا ظنيا عن الواقع.
الثاني: أن يجب العمل به، لاجل أنه يحدث فيه بسبب قيام تلك الامارة مصلحة راجحة على المصلحة الواقعية التي تفوت عند مخالفة تلك الامارة للواقع، كأن يحدث في صلاة الجمعة بسبب
إخبار العادل بوجوبها مصلحة راجحة على المفسدة في فعلها على تقدير حرمتها واقعا.
أما إيجاب العمل بالخبر على الوجه الاول، فهو وإن كان في نفسه قبيحا مع فرض إنفتاح باب العلم، لما ذكره المستدل من تحريم الحلال وتحليل الحرام، لكن لا يمتنع أن يكون الخبر أغلب مطابقة للواقع في نظر الشارع من الادلة القطعية التي يستعملها المكلف للوصول إلى الحرام والحلال الواقعيين، أو يكونا متساويين في نظره من حيث الايصال إلى الواقع.
إلا أن يقال: إن هذا رجوع إلى فرض إنسداد باب العلم والعجز عن الوصول إلى الواقع، إذ ليس المراد إنسداد باب الاعتقاد ولو كان جهلا مركبا، كما تقدم سابقا.
فالاولى الاعتراف بالقبح مع فرض التمكن عن الواقع.
وأما وجوب العمل بالخبر على الوجه الثاني، فلا قبح فيه أصلا، كما لا يخفى.
قال في النهاية في هذا المقام، تبعا للشيخ، قدس سره، في العدة: (إن الفعل الشرعي إنما يجب لكونه مصلحة، ولا يمتنع أن يكون مصلحة إذا فعلناه ونحن على صفة مخصوصة، وكوننا ظانين بصدق الراوي صفة من صفاتنا، فدخلت في جملة أحوالنا التي يجوز كون الفعل عندها مصلحة)، إنتهى موضع الحاجة.
فإن قلت: إن هذا إنما يوجب التصويب، لان المفروض على هذا أن في صلاة الجمعة التي أخبر بوجوبها مصلحة راجحة على المفسدة الواقعية.
فالمفسدة الواقعية سليمة عن المعارض الراجح بشرط عدم إخبار العادل بوجوبها، وبعد الاخبار يضمحل المفسدة، لعروض المصلحة الراجحة.
فلو ثبت مع هذا الوصف تحريم ثبت بغير مفسدة توجبه، لان الشرط في إيجاب المفسدة له خلوها عن معارضة المصلحة الراجحة.
فيكون إطلاق الحرام الواقعي حينئذ بمعنى أنه حرام لولا الاخبار، لا أنه حرام بالفعل ومبغوض واقعا، فالموجود بالفعل في هذه الواقعة عند الشارع ليس إلا المحبوبية والوجوب، فلا يصح إطلاق الحرام على ما فيه المفسدة المعارضة بالمصلحة الراجحة عليه.
ولو فرض صحته فلا يوجب ثبوت حكم شرعي مغاير للحكم المسبب عن المصلحة الراجحة.
والتصويب وإن لم ينحصر في هذا المعنى، إلا أن الظاهر بطلانه أيضا، كما إعترف به العلامة في النهاية في مسألة التصويب، وأجاب به صاحب المعالم في تعريف الفقه عن قول العلامة بأن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم.
قلت: لو سلم كون هذا تصويبا مجمعا على بطلانه وأغمضنا النظر عما سيجئ من عدم كون
ذلك تصويبا، كان الجواب به عن إبن قبة من جهة أنه أمر ممكن غير مستحيل وإن لم يكن واقعا، لاجماع أو غيره.
وهذا المقدار يكفي في رده.
إلا أن يقال: إن كلامه، قدس سره بعد الفراغ عن بطلان التصويب، كما هو ظاهر إستدلاله.
وحيث إنجر الكلام إلى التعبد بالامارات الغير العلمية، فنقول في توضيح هذا المرام وإن كان خارجا عن محل الكلام: إن ذلك يتصور على وجهين:
الاول: أن يكون ذلك من باب مجرد الكشف عن الواقع، فلا يلاحظ في التعبد بها إلا الايصال إلى الواقع، فلا مصلحة في سلوك هذا الطريق وراء مصلحة الواقع.
كما لو أمر المولى عبده عند تحيره في طريق بغداد بسؤال الاعراب عن الطريق، غير ملاحظ في ذلك إلا قول الاعراب موصلا إلى الواقع دائما أو غالبا.والامر بالعمل في هذا القسم ليس إلا للارشاد.
الثاني: أن يكون ذلك لمدخلية سلوك الامارة في مصلحة العمل وإن خالف الواقع.
فالغرض إدراك مصلحة سلوك هذا الطريق التي هى مساوية لمصلحة الواقع أو أرجح منها.
أما القسم الاول، فالوجه فيه لا يخلو من أمور: أحدها: كون الشارع العالم بالغيب عالما بدوام موافقة هذه الامارات للواقع وإن لم يعلم بذلك المكلف.
الثاني: كونها في نظر الشارع غالب المطابقة.
الثالث: كونها في نظره أغلب مطابقة من العلوم الحاصلة للمكلف بالواقع، لكون أكثرها في نظر الشارع جهلا مركبا.
والوجه الاول والثالث يوجبان الامر بسلوك الامارة ولو مع تمكن المكلف من الاسباب المفيدة للقطع.
والثاني لا يصح إلا مع تعذر باب العلم، لان تفويت الواقع على المكلف ولو في النادر من دون تداركه بشئ قبيح.
وأما القسم الثاني، فهو على وجوه:
أحدها: أن يكون الحكم - مطابقا - تابعا لتلك الامارة، بحيث لا يكون في حق الجاهل مع قطع النظر عن وجود هذه الامارة وعدمها حكم، فيكون الاحكام الواقعية مختصة في الواقع بالعالمين بها،
والجاهل مع قطع النظر عن قيام أمارة عنده على حكم العالمين لا حكم له أو محكوم بما يعلم الله أن الامارة تؤدي إليه.وهذا تصويب باطل عند أهل الصواب من المخطئة.
وقد تواتر بوجود الحكم المشترك بين العالم والجاهل الاخبار والآثار.
الثاني: أن يكون الحكم الفعلي تابعا لهذه الامارة، بمعنى: أن لله في كل واقعة حكما يشترك فيه العالم والجاهل لولا قيام الامارة على خلافه، بحيث يكون قيام الامارة المخالفة مانعا عن فعلية ذلك الحكم، لكون مصلحة سلوك هذه الامارة غالبة على مصلحة الواقع.
فالحكم الواقعي فعلي في حق غير الظان بخلافه، وشأني في حقه بمعنى وجود المقتضي لذلك الحكم لولا الظن على خلافه.
وهذا أيضا كالاول في عدم ثبوت الحكم الواقعي للظان بخلافه، لان الصفة المزاحمة بصفة أخرى لا تصير منشأ لحكم، فلا يقال للكذب النافع: إنه قبيح واقعا.
والفرق بينه وبين الوجه الاول، بعد إشتراكهما في عدم ثبوت الحكم الواقعي للظان بخلافه، أن العامل بالامارة المطابقة حكمه حكم العالم ولم يحدث في حقه بسبب ظنه حكم، نعم كان ظنه مانعا عن المانع، وهو الظن بالخلاف.
الثالث: أن لا يكون للامارة القائمة على الواقعة تأثير في الفعل الذي تضمنت الامارة حكمه ولا تحدث فيه مصلحة، إلا أن العمل على طبق تلك الامارة، والالتزام به في مقام العمل على أنه هو الواقع، وترتيب الآثار الشرعية المترتبة عليه واقعا يشتمل على مصلحة، [ فأوجبه الشارع.
ومعنى إيجاب العمل على الامارة وجوب تطبيق العمل عليها، لا وجوب إيجاد عمل على طبقها، إذ قد لا تتضمن الامارة إلزاما على المكلف.
فإذا تضمنت إستحباب شئ أو وجوبه تخييرا أو إباحته وجب عليه إذا أراد الفعل أن يوقعه على وجه الاستحباب او الاباحة بمعنى حرمة قصد غيرهما كما لو قطع بهما، ] وتلك المصلحة لا بد أن تكون مما يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع، لو كان الامر بالعمل به مع التمكن من العلم، وإلا كان تفويتا لمصلحة الواقع، وهو قبيح، كما عرفت في كلام إبن قبة.
فإن قلت: ما الفرق بين هذا الوجه الذي مرجعه إلى المصلحة في العمل بالامارة وترتيب أحكام الواقع على مؤداها وبين الوجه السابق الراجع إلى كون قيام الامارة سببا لجعل مؤداها على المكلف؟ مثلا إذا فرضنا قيام الامارة على وجوب صلاة الجمعة مع كون الواجب في الواقع هي الظهر فإن كان في فعل الجمعة مصلحة يتدارك بها ما يفوت بترك صلاة الظهر، فصلاة الظهر في حق هذا
الشخص خالية عن المصلحة الملزمة، فلا صفة تقتضي وجوبها الواقعي، فهنا وجوب واحد واقعا و ظاهرا متعلق بصلاة الجمعة، وإن لم يكن في فعل الجمعة صفة، كان الامر بالعمل بتلك الامارة قبيحا، لكونه مفوتا للواجب مع التمكن من إدراكه بالعلم.
فالوجهان مشتركان في إختصاص الحكم الواقعي بغير من قام عنده الامارة على وجوب صلاة الجمعة.
فيرجع الوجه الثالث إلى الوجه الثاني، وهو كون الامارة سببا لجعل مؤداها هو الحكم الواقعي لا غير، وإنحصار الحكم في المثال بوجوب صلاة الجمعة، وهو التصويب الباطل.
قلت: أما رجوع الوجه الثالث إلى الوجه الثاني فهو باطل، لان مرجع جعل مدلول الامارة في حقه الذي هو مرجع الوجه الثاني إلى أن صلاة الجمعة هي واجبة عليه واقعا، كالعالم بوجوب صلاة الجمعة، فإذا صلاها فقد فعل الواجب الواقعي، فإذا إنكشف مخالفة الامارة للواقع فقد إنقلب موضوع الحكم واقعا إلى موضوع آخر، كما إذا صار المسافر بعد صلاة القصر حاضرا، إذا قلنا بكفاية السفر في أول الوقت لصحة القصر واقعا.
ومعنى الامر بالعمل على طبق الامارة الرخصة في أحكام الواقع على مؤداها من دون أن يحدث في الفعل مصلحة على تقدير مخالفة الواقع، كما يوهمه ظاهر عبارتي العدة والنهاية المتقدمتين.
فإذا أدت إلى وجوب صلاة الجمعة واقعا، وجب ترتيب أحكام الوجوب الواقعي وتطبيق العمل على وجوبها الواقعي.
فإن كان في أول الوقت جاز الدخول فيها بقصد الوجوب وجاز تأخيرها.
فإذا فعلها جاز له فعل النافلة وإن حرمت في وقت الفريضة المفروض كونها في الواقع هي الظهر، لعدم وجوب الظهر عليه فعلا ورخصة في تركهما، وإن كان في آخر وقتها حرم تأخيرها والاشتغال بغيرها.
ثم إن إستمر هذا الحكم الظاهري أعني الترخيص في ترك الظهر إلى آخر وقتها - وجب كون الحكم الظاهري، لكون ما فعله في أول الوقت هو الواقع المستلزم لفوت الواقع على المكلف، مشتملا على مصلحة يتدارك بها ما فات لاجله من مصلحة الظهر، لئلا يلزم تفويت الواجب الواقعي على المكلف مع التمكن من إتيانه بتحصيل العلم به.
وإن لم يستمر بل علم بوجوب الظهر في المستقبل، بطل وجوب العمل على طبق وجوب صلاة الجمعة واقعا ووجب العمل على طبق عدم وجوبه في نفس الامر من أول الامر، لان المفروض عدم حدوث الوجوب النفس الامري، وإنما عمل على طبقه ما دامت أمارة الوجوب قائمة.
فإذا فقدت بإنكشاف وجوب الظهر وعدم وجوب الجمعة، وجب حينئذ ترتيب ما هو كبرى
لهذا المعلوم، أعني وجوب الاتيان بالظهر ونقض آثار وجوب صلاة الجمعة إلا ما فات منها.
فقد تقدم أن مفسدة فواته متداركة بالحكم الظاهري المتحقق في زمان الفوت.
فلو فرضنا العلم بعد خروج وقت الظهر، فقد تقدم أن حكم الشارع بالعمل بمؤدى الامارة اللازم منه ترخيص ترك الظهر في الجزء الاخير لا بد أن يكون لمصلحة يتدارك بها مفسدة ترك الظهر.
ثم إن قلنا: إن القضاء فرع صدق الفوت المتوقف على فوت الواجب من حيث أن فيه مصلحة، لم يجب فيما نحن فيه، لان الواجب وإن ترك إلا أن مصلحته متداركة، فلا يصدق على هذا الترك الفوت.
وإن قلنا: إنه متفرع على مجرد ترك الواجب، وجب هنا، لفرض العلم بترك صلاة الظهر مع وجوبها عليه واقعا.
إلا أن يقال: إن غاية ما يلتزم به في المقام هي المصلحة في معذورية الجاهل مع تمكنه من العلم ولو كانت لتسهيل الامر على المكلفين، ولا ينافي ذلك صدق الفوت، فافهم.
ثم إن هذا كله على ما إخترناه من عدم إقتضاء الامر الظاهري للاجزاء واضح، وأما على القول بإقتضائه له فقد يشكل الفرق بينه وبين القول بالتصويب.
وظاهر شيخنا في تمهيد القواعد إستلزام القول بالتخطئة لعدم الاجزاء.
قال قدس سره: (من فروع مسألة التصويب والتخطئة لزوم الاعادة للصلاة بظن القبلة وعدمه)، وإن كان في تمثيله لذلك بالموضوعات محل نظر.
- فعلم من ذلك أن ما ذكره من وجوب كون فعل الجمعة مشتملا على مصلحة يتدارك به مفسدة ترك الواجب ومعه يسقط عن الوجوب ممنوع، لان فعل الجمعة قد لايستلزم الا ترك الظهر في بعض أجزاء وقته، فالعمل على الامارة معناه الاذن في الدخول فيها على قصد الوجوب والدخول في التطوع بعد فعلها.
نعم يجب في الحكم بجواز فعل النافلة اشتماله على مصلحة يتدارك به مفسدة فعل التطوع في وقت الفريضة لو اشتمل دليله الفريضة المأذون في تركها ظاهرا، والا كان جواز التطوع في تلك الحال حكما واقعيا لا ظاهريا.
واما قولك انه مع تدارك المفسدة بمصلحة الحكم الظاهري يسقط الوجوب فممنوع ايضا، اذ قد يترتب على وجوبه واقعا حكم شرعي وان تدارك مفسدة تركه مصلحة فعل آخر كوجوب قضائه اذا علم بعد خروج الوقت بوجوبه واقعا.
وبالجملة، فحال الامر بالعمل بالامارة القائمة على حكم شرعي حال الامر بالعمل بالامارة القائمة على الموضوع الخارجي، كحياة زيد وموت عمرو.
فكما أن الامر بالعمل بالامارة في الموضوعات لا يوجب جعل نفس الوضوع، وإنما يوجب جعل أحكامه، فيترتب عليه الحكم ما دامت الامارة قائمة عليه، فإذا فقدت الامارة وحصل العلم بعدم ذلك الموضوع ترتب عليه في المستقبل جميع أحكام عدم ذلك الموضوع من أول الامر، فكذلك حال الامر بالعمل على الامارة القائمة على الحكم.
وحاصل الكلام ثبوت الفرق الواضح بين جعل مدلول الامارة حكما واقعيا والحكم بتحققه واقعا عند قيام الامارة وبين الحكم واقعا بتطبيق العمل على الحكم الواقعي المدلول عليه بالامارة،
كالحكم واقعا بتطبيق العمل على طبق الموضوع الخارجي الذي قامت عليه الامارة.
وأما توهم: (أن مرجع تدارك مفسدة مخالفة الحكم الواقعي، بالمصلحة الثابتة في العمل على طبق مؤدى الامارة إلى تصويب الباطل نظرا إلى خلو الحكم الواقعي حينئذ عن المصلحة الملزمة التي تكون في فوتها المفسدة).
ففيه: منع كون هذا تصويبا.
كيف والمصوبة يمنعون حكم الله في الواقع، فلا يعقل عندهم إيجاب العمل بما جعل طريقا إليه والتعبد بترتيب آثاره في الظاهر، بل التحقيق عد مثل هذا من وجوه الرد على المصوبة.
وأما ما ذكره: (من أن الحكم الواقعي إذا كانت مفسدة مخالفته متداركة بمصلحة العمل على طبق الامارة، فلو بقي في الواقع كان حكما بلا صفة، وإلا ثبت إنتقاء الحكم في الواقع.
وبعبارة أخرى: إذا فرضنا الشئ في الواقع واجبا وقامت أمارة على تحريمه، فإن لم يحرم ذلك الفعل لم يجب العمل بالامارة، وإن حرم فإن بقى الوجوب لزم إجتماع الحكمين المتضادين، وإن إنتفى ثبت إنتفاء الحكم الواقعي).
ففيه: أن المراد بالحكم الواقعي الذي يلزم بقاؤه هو الحكم المتعين المتعلق بالعباد الذي يحكي عنه الامارة ويتعلق به العلم والظن وأمر السفراء بتبليغه وإن لم يلزم إمتثاله فعلا في حق من قامت عنده أمارة على خلافه.
إلا أنه يكفي في كونه حكمه الواقعي أنه لا يعذر فيه إذا كان عالما به أو جاهل مقصرا، والرخصة في تركه عقلا، كما في الجاهل القاصر، أو شرعا، كمن قامت عنده أمارة معتبرة على خلافه.
و مما ذكرنا يظهر حال الامارة على الموضوعات الخارجية، فإنها من القسم الثالث.
والحاصل: أن المراد بالحكم الواقعي هي مدلولات الخطابات الواقعية الغير المقيدة بعلم المكلفين ولا بعدم قيام الامارة على خلافها، لها آثار عقلية وشرعية تترتب عليها عند العلم بها أو قيام أمارة حكم الشارع بوجوب البناء على كون مؤداها هو الواقع.نعم هذه ليست أحكاما فعليه بمجرد وجودها الواقعى.
فتلخص من جميع ما ذكرناه أن ذكره إبن قبة من إستحالة التعبد بخبر الواحد أو بمطلق الامارة الغير العلمية - ممنوع على إطلاقه، وإنما يصح، إذا ورد التعبد على بعض الوجوه، كما تقدم تفصيل ذلك.
ثم إنه ربما ينسب إلى بعض: (إيجاب التعبد بخبر الواحد أو بمطلق الامارة على الله تعالى.
بمعنى قبح تركه منه)، في مقابل قول إبن قبة.
فإن أراد به وجوب إمضاء حكم العقل بالعمل به عند عدم التمكن من العلم ببقاء التكليف، فحسن.
وإن أراد وجوب الجعل بالخصوص في حال الانسداد، فممنوع، إذ جعل الطريق بعد إنسداد باب العلم إنما يجب عليه إذا لم يكن هناك طريق عقلي وهو الظن.
إلا أن يكون لبعض الظنون في نظره خصوصية.
وإن أراد حكم صورة الانفتاح: فإن أراد وجوب التعبد العيني، فهو غلط، لجواز تحصيل العلم معه قطعا، وإن أراد وجوب التعبد به تخييرا، فهو مما لا يدركه العقل، إذ لا يعلم العقل بوجود مصلحة في الامارة يتدارك بها مصلحة الواقع التي تفوت بالعمل بالامارة، اللهم إلا أن يكون في تحصيل العلم حرج يلزم في العقل رفع إيجابه بنصب أمارة هي أقرب من غيرها إلى الواقع أو أصح في نظر الشارع من غيره في مقام البدلية عن الواقع، وإلا فيكفي إمضاؤه للعمل بمطلق الظن، كصورة الانسداد.
المقام الثاني: في وقوع التعبد بالظن في الاحكام الشرعية
ثم إذا تبين عدم إستحالة تعبد الشارع بغير العلم وعدم القبح فيه ولا في تركه، فيقع الكلام في المقام الثاني في وقوع التعبد به في الاحكام الشرعية مطلقا أو في الجملة.
وقبل الخوض في ذلك لا بد من تأسيس الاصل الذي يكون عليه المعول عند عدم الدليل على وقوع التعبد بغير العلم مطلقا أو في الجملة فنقول: التعبد بالظن، الذي لم يدل دليل على التعبد به، محرم بالادلة الاربعة.
ويكفي من الكتاب قوله تعالى: (قل الله أذن لكم أم على الله تفترون)، دل على أن ما ليس بإذن من الله من إسناد الحكم إلى الشارع فهو إفتراء، ومن السنة قوله، صلى الله عليه وآله، في عداد القضاة من أهل النار: (ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم)، ومن الاجماع ما إدعاه الفريد البهبهاني، في بعض رسائله، من كون عدم الجواز بديهيا عند العوام فضلا عن العلماء، ومن العقل تقبيح العقلاء من يتكلف من قبل مولاه بما لا يعلم بوروده عن المولى ولو كان عن جهل مع التقصير.نعم، قد يتوهم متوهم أن الاحتياط من هذا القبيل.
وهو غلط واضح، إذ فرق بين الالتزام بشئ من قبل المولى على أنه منه مع عدم العلم بأنه منه، وبين الالتزام بإتيانه لاحتمال كونه منه أو رجاء كونه منه.
وشتان ما بينهما، لان العقل يستقل بقبح الاول وحسن الثاني.
والحاصل: أن المحرم هو العمل بغير العلم متعبدا به ومتدينا به.
وأما العمل به من دون تعبد بمقتضاه: فإن كان لرجاء إدراك الواقع، فهو حسن ما لم يعارضه إحتياط آخر أو لم يثبت من دليل آخر وجوب العمل على خلافه، كما لو ظن الوجوب واقتضى الاستصحاب الحرمة، فإن الاتيان بالفعل محرم وإن لم يكن على وجه التعبد بوجوبه والتدين به.
وإن لم يكن لرجاء إدراك الواقع، فإن لزم منه طرح أصل دل الدليل على وجوب الاخذ به حتى يعلم خلافه، كان محرما أيضا، لان فيه طرحا للاصل الواجب العمل، كما فيما ذكر، من مثال كون الظن بالوجوب على خلاف إستصحاب التحريم، وإن لم يلزم منه ذلك جاز العمل، كما لو ظن بوجوب ما تردد بين الحرمة والوجوب، فإن الالتزام بطرف الوجوب لا على أنه حكم الله المعين جائز.
لكن في تسمية هذا عملا بالظن مسامحة، وكذا في تسمية الاخذ به من باب الاحتياط.
وبالجملة، فالعمل بالظن إذا لم يصادف الاحتياط محرم إذا وقع على وجه التعبد به والتدين، سواء إستلزم طرح الاصل أو الدليل الموجود في مقابله أم لا، وإذا وقع على غير وجه التعبد به فهو محرم إذا إستلزم طرح ما يقابله من الاصول والادلة المعلوم وجوب العمل بها، هذا.
وقد يقرر (الاصل) هنا بوجوه أخر: منها: أن الاصل عدم الحجية وعدم وقوع التعبد به وإيجاب العمل به.
وفيه: أن الاصل وإن كان ذلك إلا أنه لا يترتب على مقتضاه شئ، فإن حرمة العمل بالظن يكفي في موضوعها عدم العلم بورود التعبد من غير حاجة إلى إحراز عدم ورود التعبد به، ليحتاج في ذلك إلى الاصل ثم إثبات الحرمة.
والحاصل: أن أصالة عدم الحادث إنما يحتاج إليها في الاحكام المترتبة على عدم ذلك الحادث.
وأما الحكم المرتب على عدم العلم بذلك الحادث فيكفي فيه الشك فيه ولا يحتاج إلى إحراز عدمه بحكم الاصل.
وهذا نظير قاعدة الاشتعال الحاكمة بوجوب اليقين بالفراغ، فإنه لا يحتاج في إجرائها إلى إجراء أصالة عدم فراغ الذمة، بل يكفي فيها عدم العلم بالفراغ، فتأمل.
ومنها: أن الاصل هي إباحة العمل بالظن، لانها الاصل في الاشياء.
حكاه بعض عن السيد المحقق الكاظمي.
وفيه: على تقدير النسبة، أولا، أن إباحة التعبد بالظن غير معقول، إذ لا معنى لجواز التعبد وتركه لا إلى بدل.
غاية الامر التخيير بين التعبد بالظن والتعبد بالاصل أو الدليل الموجود هناك في مقابله الذي يتعين الرجوع إليه لولا الظن.
فغاية الامر وجوب التعبد به أو بالظن تخييرا،
فلا معنى للاباحة التي هي الاصل في الاشياء.
وثانيا، أن أصالة الاباحة إنما هي فيما لا يستقل العقل بقبحه، وقد عرفت إستقلال العقل بقبح التعبد بالظن من دون العلم بوروده من الشارع.
ومنها: أن الامر في المقام دائر بين الوجوب والتحريم، ومقتضاه التخيير أو ترجيح جانب التحريم، بناء على أن دفع المفسده أولى من جلب المنفعة.
وفيه: منع الدوران، لان عدم العلم بالوجوب كاف في ثبوت التحريم، لما عرفت من إطباق الادلة الاربعة على عدم جواز التعبد بما لا يعلم وجوب التعبد به من الشارع.
ألا ترى أنه إذا دار الامر بين رجحان عبادة وحرمتها كفى عدم ثبوت الرجحان في ثبوت حرمتها.
ومنها: أن الامر في المقام دائر بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد بالاحكام الشرعية المعلومة إجمالا وبين وجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعى، فيرجع إلى الشك في المكلف به وتردده بين التخيير والتعيين، فيحكم بتعيين تحصيل خصوص الاعتقاد القطعى تحصيلا لليقين بالبراءة، خلافا لمن لم يوجب ذلك في مثل المقام.
وفيه: أولا، أن وجوب تحصيل الاعتقاد بالاحكام مقدمة عقلية للعمل بها وامتثالها، فالحاكم بوجوبه هو العقل.
ولا معنى لتردد العقل في موضوع حكمه وأن الذي حكم هو بوجوبه تحصيل مطلق الاعتقاد أو خصوص العلم منه، بل إما أن يستقل بوجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي على ما هو التحقيق، وإما أن يحكم بكفاية مطلق الاعتقاد.
ولا يتصور الاجمال في موضوع الحكم العقلي، لان التردد في الموضوع يستلزم التردد في الحكم، وهو لا يتصور من نفس الحاكم.
و سيجئ الاشارة إلى هذا في رد من زعم أن نتيجة دليل الانسداد مهملة مجملة، مع عدم دليل الانسداد دليلا عقليا وحكما يستقل به العقل.
وأما ثانيا، فلان العمل بالظن في مورد مخالفته للاصول والقواعد الذي هو محل الكلام مخالفة قطعية لحكم الشارع بوجوب الاخذ بتلك الاصول حتى يعلم خلافها.
فلا حاجة في رده إلى مخالفته لقاعدة الاشتغال الراجعة إلى قدح المخالفة الاحتمالية للتكليف المتيقن.
مثلا إذا فرضنا أن الاستصحاب يقتضي الوجوب والظن حاصل بالحرمة، فحينئذ يكون العمل بالظن مخالفة قطعية لحكم الشارع بعدم نقض اليقين بغير اليقين، فلا يحتاج إلى تكلف أن التكليف بالواجبات و المحرمات يقيني، ولا نعلم كفاية تحصيل مطلق الاعتقاد الراجح فيها أو وجوب تحصيل الاعتقاد القطعي وأن في تحصيل الاعتقاد الراجح مخالفة إحتمالية للتكليف المتيقن فلا يجوز.
فهذا أشبه شئ بالاكل عن القفا.
فقد تبين مما ذكرنا أن ما ذكرنا في بيان الاصل هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه.
وحاصله: أن التعبد بالظن مع الشك في رضاء الشارع بالعمل به في الشريعة تعبد بالشك، وهو باطل عقلا ونقلا.
وأما مجرد العمل على طبقه فهو محرم إذا خالف أصلا من الاصول اللفظية أو العملية الدالة على وجوب الاخذ بمضمونها حتى يعلم الرافع.
فالعمل بالظن قد تجتمع فيه جهتان للحرمة، كما إذا عمل به ملتزما أنه حكم الله، وكان العمل به مخالفا لمقتضى الاصول، وقد تحقق فيه جهة واحدة، كما إذا خالف الاصل ولم يلتزم بكونه حكم الله، أو التزم ولم يخالف مقتضى الاصول، وقد لا يكون فيه عقاب أصلا، كما إذا لم يلتزم بكونه حكم الله ولم يخالف أصلا.
وحينئذ قد يستحق عليه الثواب، كما إذا عمل به على وجه الاحتياط، هذا.
ولكن حقيقة العمل بالظن هو الاستناد إليه في العمل والالتزام بكون مؤداه حكم الله في حقه، فالعمل على ما يطابقه بلا إستناد إليه ليس عملا به.
فصح أن يقال: إن العمل بالظن والتعبد به حرام مطلقا، وافق الاصول أو خالفها.
غاية الامر أنه إذا خالف الاصول يستحق العقاب من جهتين، من جهة الالتزام والتشريع ومن جهة طرح الاصل المأمور بالعمل به حتى يعلم بخلافه.
وقد أشير في الكتاب والسنة إلى الجهتين: فمما أشير فيه إلى الاولى قوله تعالى: (قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون)، بالتقريب المتقدم.
وقوله صلى الله عليه وآله: (رجل قضى بالحق وهو لا يعلم).
ومما أشير فيه إلى الثانية قوله تعالى: (إن الظن لا يغني من الحق شيئا) وقوله عليه السلام: (من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه)، ونفس أدلة الاصول.
ثم إن ما ذكرنا من الحرمة من الجهتين مبني على ما هو التحقيق، من أن إعتبار الاصول، لفظية كان أو عملية، غير مقيد بصورة عدم الظن على خلافها.
وأما إذا قلنا بإشتراط عدم كون الظن عى خلافها، فلقائل أن يمنع أصالة حرمة العمل بالظن مطلقا، لا على وجه الالتزام ولا على غيره.
أما مع عدم تيسر العلم في المسألة، فلدوران الامر فيها بين العمل بالظن وين الرجوع إلى
الاصل الموجود في تلك المسألة على خلاف الظن.
وكما لا دليل على التعبد بالظن، كذلك لا دليل على التعبد بذلك الاصل، لانه المفروض.
فغاية الامر التخيير بينهما أو تقديم الظن، لكونه أقرب إلى الواقع، فيتعين بحكم العقل.
وأما مع التمكن من العلم في المسألة، فلان عدم جواز الاكتفاء فيها بتحصيل الظن ووجوب تحصيل اليقين مبني على القول بوجوب تحصيل الواقع علما.
أما إذا أدعي أن العقل لا يحكم بأزيد من وجوب تحصيل الظن وأن الضرر الموهوم لا يجب دفعه، فلا دليل على لزوم تحصيل العلم مع التمكن.
ثم إنه ربما يستدل على أصالة حرمة العمل بالظن بالآيات الناهية عن العمل بالظن، وقد أطالوا الكلام في النقض والابرام في هذا المقام بما لا ثمرة مهمة في ذكره بعدما عرفت.
لانه إن أريد الاستدلال بها على حرمة التعبد والالتزام والتدين بمؤدى الظن، قد عرفت أنه من ضروريات العقل، فضلا عن تطابق الادلة الثلاثة النقلية عليه.
وإن اريد دلالتها على حرمة العمل المطابق للظن وإن لم يكن عن إستناد إليه: فإن أريد حرمته إذا خالف الواقع مع التمكن من العلم به، فيكفي في ذلك الادلة الواقعية، وإن أريد حرمته إذا خالف الاصول مع عدم التمكن من العلم، فيكفي فيه أيضا أدلة الاصول، بناء على ما هو التحقيق، من أن مجاريها صور عدم العلم الشامل للظن، وإن أريد حرمة العمل المطابق للظن من دون إستناد إليه وتدين به وعدم مخالفة العمل للواقع مع التمكن منه ولا لمقتضى الاصول مع العجز عن الواقع، فلا دلالة فيها ولا في غيرها على حرمة ذلك، ولا وجه لحرمته أيضا.
والظاهر أن مضمون الايات هو التعبد بالظن والتدين به، وقد عرفت أن ضروري التحريم، فلا مهم في إطالة الكلام في دلالةالايات وعدمها.
* * *
إنما المهم الموضوع له هذه الرسالة بيان ما خرج او قيل بخروجه من هذا الاصل من الامور الغير العلمية التي أقيم الدليل على إعتبارها مع قطع النظر عن إنسداد باب العلم الذي جعلوه موجبا للرجوع إلى الظن مطلقا أو في الجملة، وهي أمور:
الظنون المعتبرة
منها: الامارات المعمولة في إستنباط الاحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب والسنة وهي على قسمين:
القسم الاول: ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند إحتمال إرادة خلاف ذلك، كأصالة الحقيقة عند إحتمال إرادة المجاز، وأصالة العموم والاطلاق، ومرجع الكل إلى أصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة، وكغلبة إستعمال المطلق في الفرد الشائع بناء على عدم وصوله إلى حدالوضع، وكالقرائن المقامية التي يعتمدها أهل اللسان في محاوراتهم، كوقوع الامر عقيب توهم الحظر ونحو ذلك، وبالجملة الامور المعتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم، بحيث لو أراد المتكلم القاصد للتفهيم خلاف مقتضاها من دون نصب قرينة معتبرة عد ذلك منه قبيحا.
والقسم الثاني: ما يعمل لتشخيص أوضاع الالفاظ وتمييز مجازاتها عن حقائقها وظواهرها عن خلافها، كتشخيص أن لفظ (الصعيد) موضوع لمطلق وجه الارض أو التراب الخالص، وتعيين أن وقوع الامر عقيب توهم الحظر هل يوجب ظهوره في الاباحة المطلقة، وأن الشهرة في المجاز المشهور هل توجب إحتياج الحقيقة إلى القرينة الصارفة من الظهور العرضي المسبب من الشهرة، نظير إحتياج المطلق المنصرف إلى بعض أفراده.
وبالجملة، فالمطلوب في هذا القسم أن اللفظ ظاهر في هذا المعنى أو غير ظاهر، وفي القسم الاول أن الظاهر المفروغ عن كونه ظاهرا مراد أولا.
والشك في الاول مسبب عن الاوضاع اللغوية والعرفية وفي الثاني عن إعتماد المتكلم على القرينة وعدمه.
فالقسمان من قبيل الصغرى والكبرى لتشخيص المراد.
القسم الاول وهو ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم
فاعتباره في الجملة مما لا إشكال فيه ولا خلاف، لان المفروض كون تلك الامور معتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم المقصود بها التفهيم، ومن المعلوم بديهة أن طريق محاورات الشارع في تفهيم مقاصده للمخاطبين لم يكن طريقا مخترعا مغايرا لطريق محاورات أهل اللسان في تفهيم مقاصدهم.
وإنما الخلاف والاشكال وقع في موضعين:
أحدهما: جواز العمل بظواهر الكتاب.
والثاني: أن العمل بالظواهر مطلقا في حق غير المخالطب بها قام الدليل عليه بالخصوص بحيث لا يحتاج إلى إثبات إنسداد باب العلم في الاحكام الشرعية أم لا.
والخلاف الاول ناظر إلى عدم كون المقصود بالخطاب إستفادة المطلب منه مستقلا.
والخلاف الثاني ناظر إلى منع كون المتعارف بين أهل اللسان إعتماد غير من قصد إفهامه بالخطاب على ما يستفيده من الخطاب بواسطة أصالة عدم القرينة عند التخاطب.
فمرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى.
وأما الكبرى أعني كون الحكم عند الشارع في إستنباط مراداته من خطاباته المقصودة بها التفهيم ما هو المتعارف عند أهل اللسان في الاستفادة فمما لا خلاف فيه ولا إشكال.
* * *
أما الكلام في الخلاف الاول فتفصيله أنه ذهب جماعة من الاخباريين إلى المنع عن العمل بظواهر الكتاب من دون ما يرد التفسير وكشف المراد عن الحجج المعصومين صلوات الله عليهم.
وأقوى ما يتمسك لهم على ذلك وجهان أحدهما: الاخبار المتواترة المدعى ظهورها في المنع عن ذلك مثل النبوي صلى الله عليه وآله: (من فسر القرآن برأيه فليتبوء مقعده من النار) وفي رواية أخرى: (من قال في القرآن بغير علم فليتبوء مقعده من النار).
وفي نبوي ثالث: (من فسر القرآن برأيه فقد إفترى على الله الكذب).
وعن أبي عبدالله عليه السلام: (من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجرو إن أخطأ سقط أبعد من السماء).
وفي النبوي العامي: (من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ).
وعن مولانا الرضا، عليه السلام، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إن الله عزوجل قال في الحديث القدسي: ما آمن بي من فسر كلامي برأيه، وما عرفني من شبهني بخلقي، وما على ديني من إستعمل القياس في ديني).
وعن تفسير العياشي عن أبي عبدالله عليه السلام: (قال: من حكم برأيه بين إثنين فقد كفر، و من فسر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر).
وعن مجمع البيان: (إنه قد صرح عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الائمة القائمين مقامه: أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالاثر الصحيح والنص الصريح).
وقوله عليه السلام: (ليس شئ أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن.
إن الاية يكون أولها في شئ وآخرها في شئ، وهو كلام متصل ينصرف إلى وجوه).
وفي مرسلة شبيب بن أنس عن أبي عبدالله عليه السلام: (إنه قال لابي حنيفة: أنت فقيه أهل العراق؟ قال: نعم.
قال: فبأي شئ تفتيهم؟ قال: بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله قال: يا أبا حنيفة ! تعرف كتاب الله حق معرفته وتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: نعم.
قال عليه السلام: يا أبا حنيفة ! لقد إدعيت علما، ويلك، ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم، ويلك، وما هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا صلى الله عليه وآله، وما ورثك الله من كتابه حرفا).
وفي رواية زيد الشحام: (قال: دخل قتادة على أبي جعفر عليه السلام، فقال له: أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا يزعمون، فقال: بلغني أنك تفسر القرآن، قال: نعم إلى أن قال -: يا قتادة ! إن كنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت قد فسرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت.
ويحك ! يا قتادة ! إنما يعرف القرآن من خوطب به).
إلى غير ذلك مما ادعى في الوسائل، في كتاب القضاء، تجاوزها عن حد التواتر.
وحاصل هذا الوجه يرجع إلى أن منع الشارع عن ذلك يكشف عن أن مقصود المتكلم ليس تفهيم مطالبه بنفس هذا الكلام، فليس من قبيل المحاورات العرفية.
والجواب عن الاستدلال بها أنها لا تدل على المنع عن العمل بالظواهر الواضحة المعنى بعد الفحص عن نسخها وتخصيصها وإرادة خلاف ظاهرها في الاخبار.
إذ من المعلوم أن هذا لا يسمى تفسيرا، فإن أحدا من العقلاء إذا رأى في كتاب مولاه أنه أمره بشئ بلسانه المتعارف في مخاطبته له، عربيا أو فارسيا أو غيرهما، فعمل به وامتثله، لم يعد هذا تفسيرا، إذ التفسير كشف القناع.
ثم لو سلم كون مطلق حمل اللفظ على معناه تفسيرا، لكن الظاهر أن المراد بالرأي هو الاعتبار
العقلي الظني الراجح إلى الاستحسان، فلا يشمل حمل ظواهر الكتاب على معانيها اللغوية والعرفية.
وحينئذ فالمراد بالتفسير بالرأي: إما حمل اللفظ على خلاف ظاهره أو أحد إحتماليه، لرجحان ذلك في نظره القاصر وعقله الفاتر.
ويرشدإليه المروي عن مولانا الصادق، عليه السلام، قال في حديث طويل: (وإنما هلك الناس في المتشابه، لانهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته.
فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم، واستغنوا بذلك عن مسألة الاوصياء عليهم السلام، فيعرفونهم).
وإما الحمل على ما يظهر له في بادي الرأي من المعاني العرفية واللغوية، من دون تأمل في الادلة العقلية ومن دون تتبع في القرائن النقلية، مثل الآيات الاخر الدالة على خلاف هذا المعنى و الاخبار الواردة في بيان المراد منها وتعيين ناسخها من منسوخها.
ومما يقرب هذا المعنى الثاني، وإن كان الاول أقرب عرفا، أن المنهي، في تلك الاخبار، المخالفون الذين يستغنون بكتاب الله عن أهل البيت، عليهم السلام، بل يخطئونهم به.
ومن المعلوم ضرورة من مذهبنا تقديم نص الامام، عليه السلام، على ظاهر القرآن، كما أن المعلوم ضرورة من مذهبهم العكس.
ويرشدك إلى هذا ما تقدم في رد الامام، (ع)، على أبي حنيفة حيث أنه يعمل بكتاب الله.
ومن المعلوم أنه إنما كان يعمل بظواهره، لا أنه كان يؤوله بالرأي، إذ لا عبرة بالرأي عندهم مع الكتاب والسنة.
ويرشد إلى هذا قول أبي عبدالله، عليه السلام، في ذم المخالفين: (إنهم ضربوا القرآن بعضه ببعض، واحتجوا بالمنسوخ وهو يظنون انه الناسخ، واحتجوا بالخاص وهو يظنون أنه العام، واحتجوا بالاية وتركوا السنة في تأوليها ولم ينظروا إلى ما يفتح به الكلام وإلى ما يختمه ولم يعرفوا موارده ومصادره إذ لم يأخذوه عن أهله فضلوا وأضلوا).
وبالجملة، فالانصاف: يقتضي عدم الحكم بظهور الاخبار المذكورة في النهي عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص والتتبع في سائر الادلة، خصوصا الاثار الواردة عن المعصومين عليهم السلام، كيف، ولو دلت على المنع من العمل على هذا الوجه دلت على عدم جواز العمل بأحاديث أهل
البيت عليه السلام.
ففي رواية سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه السلام: (إن أمر النبي صلى الله عليه وآله مثل القرآن، منه ناسخ ومنسوخ، وخاص وعام ومحكم ومتشابه، وقد كان يكون من رسول الله " ص " الكلام، يكون له وجهان، كلام عام وكلام خاص، مثل القرآن).
وفي رواية أسلم بن مسلم: (إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن).
هذا كله مع معارضة الاخبار المذكورة بأكثر منها، مما يدل على جواز التمسك بظاهر القرآن: مثل خبر الثقلين المشهور بين الفريقين، وغيرها، مما دل على الامر بالتمسك بالقرآن والعمل بما فيه، وعرض الاخبار المتعارضة بل ومطلق الاخبار عليه، ورد الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقود والاخبار الدالة قولا وفعلا وتقريرا على جواز التمسك بالكتاب.
مثل قوله، عليه السلام، لما قال زرارة: (من أين علمت أن المسح ببعض الرأس؟ فقال عليه السلام: لمكان الباء).
فعرفه مورد إستفادة الحكم من ظاهر الكتاب.
وقول الصادق، عليه السلام، في مقام نهي الدوانقي عن قبول خبر النمام: (إنه فاسق، وقال الله: إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا، الاية).
وقوله عليه السلام: لابنه إسماعيل: (إن الله عزوجل يقول: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم).
وقوله، عليه السلام، لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء، إعتذارا بأنه لم يكن شيئا أتاه برجله: (أما سمعت قول الله عزوجل: إن السمع والبصر والفواد كل أولئك كان عنه مسئولا).
وقوله، عليه السلام، في تحليل العبد للمطلقة ثلاثا: (إنه زوج، قال الله عزوجل: حتى ينكح زوجا غيره) وفي عدم تحليلها بالعقد المنقطع: إنه تعالى قال: فإن طلقها فلا جناح عليهما).
وتقريره، عليه السلام، التمسك بقوله تعالى: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب)، وأنه نسخ بقوله تعالى (ولا تنكحوا المشركات).
وقوله، عليه السلام: في رواية عبدالاعلى، في حكم من عثر، فوقع ظفره، فجعل على إصبعه مرارة: (إن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله: ما جعل عليكم في الدين من حرج.
ثم قال: إمسح عليه)، فأحال، عليه السلام، معرفة حكم المسح على إصبعه المغطى بالمرارة إلى الكتاب، موميا إلى أن هذا لا يحتاج إلى السؤال، لوجوده في ظاهر القرآن.
ولا يخفى أن إستفادة الحكم المذكور من ظاهر الاية الشريفة مما لا يظهر إلا للمتأمل المدقق، نظرا إلى أن الاية الشريفة إنما تدل على نفي وجوب الحرج، أعني المسح على نفس الاصبع، فيدور الامر في بادي النظر بين سقوط المسح رأسا وبين بقائه مع سقوط قيد مباشرة الماسح للممسوح، فهو بظاهره لا يدل على ما حكم به الامام، عليه السلام، لكن يعلم عند التأمل أن الموجب للحرج هو إعتبار المباشرة في المسح، فهو الساقط دون أصل المسح، فيصير نفي الحرج دليلا على سقوط إعتبار المباشرة في المسح، فيمسح على الاصبع المغطى.
فإذا أحال الامام، عليه السلام، إستفادة مثل هذا الحكم إلى الكتاب، فكيف يحتاج نفي وجوب الغسل أو الوضوء، عند الحرج الشديد المستفاد من ظاهر الاية المذكورة، أو غير ذلك من الاحكام التي يعرفها كل عارف باللسان من ظاهر القرآن، إلى ورود التفسير بذلك من أهل البيت عليهم السلام.
ومن ذلك ما ورد من: (أن المصلي أربعا في السفر إن قرئت عليه آية القصر وجب عليه الاعادة، وإلا فلا).
وفي بعض الروايات (إن قرئت عليه وفسرت له).
والظاهر ولو بحكم أصالة الاطلاق في باقي الروايات أن المراد من تفسيرها له بيان أن المراد من قوله تعالى: (لا جناح عليكم أن تقصروا)، بيان الترخيص في أصل تشريع القصر وكونه مبنيا على التخفيف، فلا ينافي تعين القصر على المسافر وعدم صحة الاتمام منه، ومثل هذه المخالفة للظاهر يحتاج إلى التفسير بلا شبهة.
وقد ذكر زرارة ومحمد بن مسلم للامان، عليه السلام،: (إن الله تعالى قال: (فليس عليكم جناح)، ولم يقل: إفعلوا، فأجاب، عليه السلام، بأنه من قبيل قوله تعالى: (فمن حج البيت أو إعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما).
وهذا أيضا يدل على تقرير الامام عليه السلام لهما في التعرض لاستفادة الاحكام من الكتاب
والدخل والتصرف في ظواهره.
ومن ذلك إستشهاد الامام عليه السلام بآيات كثيرة، مثل الاستشهاد لحلية بعض النسوان بقوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم)، وفي عدم جواز طلاق العبد بقوله تعالى: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ).
ومن ذلك الاستشهاد لحلية بعض الحيوانات بقوله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، الاية).
إلى غير ذلك مما لا يحصى.
الثاني: من وجهي المنع إنا نعلم بطرو التقييد والتخصيص والتجوز في أكثر ظواهرالكتاب.
وذلك مما يسقطها عن الظهور.
وفيه أولا، النقض بظواهر السنة، فإنا نقطع بظرو مخالفة الظاهر في أكثرها.
وثانيأ، أن هذا لا يوجب السقوط، وإنما يوجب الفحص عما يوجب مخالفة الظاهر.
فإن قلت: العلم الاجمالي بوجود مخالفات الظواهر لا يرتفع أثره، وهو وجوب التوقف بالفحص، ولذا لو تردد اللفظ بين معنيين أو علم إجمالا بمخالفة أحد الظاهرين لظاهر الاخر كما في العامين من وجه وشبههما - وجب التوقف فيه ولو بعد الفحص.
قلت: هذه شبهة ربما تورد على من إستدل على وجوب الفحص عن المخصص في العمومات بثبوت العلم الاجمالي بوجود المخصصات.
فإن العلم الاجمالي إما أن يبقى أثره ولو بعد العلم التفصيلي بوجود عدة مخصصات، وإما أن لا يبقى.
فإن بقي فلا يرتفع بالفحص، وإلا فلا مقتضي للفحص.
وتندفع هذا الشبهة: بأن المعلوم إجمالا هو وجود مخالفات كثيرة في الواقع فيما بأيدينا بحيث تظهر تفصيلا بعد الفحص.
وأما وجود مخالفات في الواقع زائدا على ذلك فغير معلوم.
فحينئذ لا يجوز العمل قبل الفحص، لاحتمال وجود مخصص يظهر بعد الفحص، ولا يمكن نفيه بالاصل لاجل العلم الاجمالي.
وأما بعد الفحص فإحتمال وجود المخصص في الواقع ينفى بالاصل السالم عن
العلم الاجمالي.
والحاصل: أن المنصف لا يجد فرقا بين ظاهر الكتاب والسنة، لا قبل الفحص ولا بعده.
* * *
ثم إنك قد عرفت أن العمدة في منع الاخباريين من العمل بظواهر الكتاب هي الاخبار المانعة عن تفسير القرآن.
إلا أنه يظهر من كلام السيد الصدر شارح الوافية، في آخر كلامه، أن المنع عن العمل بظواهر الكتاب هو مقتضى الاصل.
والعمل بظواهر الاخبار خرج بالدليل، حيث قال بعد إثبات أن في القرآن محكمات وظواهر وأنه مما لا يصح إنكاره، وينبغي النزاع في جواز العمل بالظواهر وأن الحق مع الاخباريين - ما خلاصته: (إن التوضيح يظهر بعد مقدمتين.
الاولى: أن بقاء التكليف مما لا شك فيه، ولزوم العمل بمقتضاه موقوف على الافهام، وهو يكون في الاكثر بالقول، ودلالته في الاكثر تكون ظنية، إذ مدار الافهام على إلقاء الحقائق مجردة عن القرينة وعلى ما يفهمون وإن كان إحتمال التجوز وخفاء القرينة باقيا.
الثانية: أن المتشابه كما يكون في أصل اللغة كذلك يكون بحسب الاصطلاح، مثل أن يقول أحد: (أنا أستعمل العمومات، وكثيرا ما أريد الخصوص من غير قرينة، وربما أخاطب أحدا وأريد غيره، ونحو ذلك).
فحينئذ لا يجوز لنا القطع بمراده ولا يحصل لنا الظن به.
والقرآن من هذا القبيل، لانه نزل على إصطلاح خاص.
لا أقول على وضع جديد، بل أعم من أن يكون ذلك أو يكون فيه مجازات لا يعرفها العرب، ومع ذلك قد وجدت فيه كلمات لا يعلم المراد منها، كالمقطعات.
ثم قال: - قال سبحانه: (فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات)، الاية، ذم على إتباع المتشابه، ولم يبين لهم المتشابهات: ماهي، وكم هي، بل لم يبين لهم المراد من هذا اللفظ، وجعل البيان موكولا إلى خلفائه، والنبي، صلى الله عليه وآله، نهى الناس عن التفسير بالاراء.
وجعلوا الاصل عدم العمل بالظن إلا ما أخرجه الدليل.
إذا تمهدت المقدمتان، فنقول: مقتضى الاولى العمل بالظواهر ومقتضى الثانية عدم العمل، لان ما صار متشابها لا يحصل الظن بالمراد منه وما بقي ظهوره مندرج في الاصل المذكور.
فنطالب بدليل جواز العمل، لان الاصل الثابت عند الخاصة هو عدم جواز العمل بالظن إلا ما أخرجه الدليل.
لا يقال: إن الظاهر من المحكم ووجوب العمل بالمحكم إجماعي.
لانا نمنع الصغرى، إذ المعلوم عندنا مساواة المحكم للنص.
وأما شموله للظاهر فلا إلى أن قال: - لا يقال: إن ما ذكرتم لو تم لدل على عدم جواز العمل بظواهر الاخبار أيضا، لما فيها من الناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، والعام والمخصص، والمطلق والمقيد.
لانا نقول: إنا لو خلينا وأنفسنا، لعملنا بظواهر الكتاب والسنة مع عدم نصب القرينة على خلافها.
ولكن منعنا من ذلك في القرآن للمنع من إتباع المتشابه و عدم بيان حقيقته، ومنعنا رسول الله، صلى الله عليه وآله، عن تفسير القرآن.
ولا ريب في أن غير النص محتاج إلى التفسير.
وأيضا ذم الله تعالى من إتباع الظن، وكذا الرسول، صلى الله عليه وآله، وأوصيائه عليهم السلام، ولم يستثنوا ظواهر القرآن إلى أن قال: - وأما الاخبار، فقد سبق أن أصحاب الائمة، عليهم السلام، كانوا عاملين باخبار الاحاد من غير فحص عن مخصص أو معارض ناسخ أو مقيد، ولولا هذا لكنا في العمل بظواهر الاخبار أيضا من المتوقفين)، إنتهى.
أقول: وفيه مواقع للنظر، سيما في جعل العمل بظواهر الاخبار من جهة قيام الاجماع العملي، ولولاه لتوقف في العمل بها أيضا، إذ لا يخفى أن عمل أصحاب الائمة، عليهم السلام، بظواهر الاخبار لم يكن لدليل خاص شرعي وصل إليهم من أئمتهم، وإنما كان أمرا مركوزا في أذهانهم بالنسبة إلى مطلق الكلام الصادر من المتكلم لاجل الافادة والاستفادة، سواء كان من الشارع أم غيره.
وهذا المعنى جار في القرآن أيضا على تقدير كونه ملقى للافادة والاستفادة على ما هو الاصل في خطاب كل متكلم.
نعم، الاصل الاولي هي حرمة العمل بالظن، على ما عرفت مفصلا.
لكن
الخارج منه ليس خصوص ظواهر الاخبار حتى يبقى الباقي، بل الخارج منه هو مطلق الظهور الناشي عن كلام كل متكلم ألقي إلى غيره للافهام.
ثم إن ما ذكره من عدم العلم بكون الظواهر من المحكمات وإحتمال كونها من المتشابهات ممنوع: أولا، بأن المتشابه لا يصدق على الظواهر، لا لغة ولا عرفا، بل يصح سلبه عنه.
فالنهي الوارد عن إتباع المتشابه لا يمنع، كما إعترف به في المقدمة الاولى، من أن مقتضى القاعدة وجوب العمل بالظواهر.
وثانيا، بأن إحتمال كونها من المتشابه لا ينفع في الخروج عن الاصل الذي اعترف به.
ودعوى إعتبار العلم بكونها من المحكم هدم لما إعترف به من أصالة حجية الظواهر، لان مقتضى ذلك الاصل جواز العمل إلا أن يعلم كونه مما نهى الشارع عنه.
وبالجملة، فالحق ما اعترف به، قدس سره، من أنا لو خلينا وأنفسنا، لعملنا بظواهر الكتاب.
ولا بد للمانع من إثبات المنع.
ثم إنك قد عرفت مما ذكرنا أن خلاف الاخباريين في ظواهر الكتاب ليس في الوجه الذي ذكرنا، من إعتبار الظواهر اللفظية في الكلمات الصادرة لافادة المطلب وإستفادته.
وإنما يكون خلافهم في أن خطابات الكتاب لم يقصد بها إستفادة المراد من أنفسها، بل بضميمة تفسير أهل الذكر أو أنها ليست بظواهر بعد إحتمال كون محكمها من المتشابه، كما عرفت من كلام السيد المتقدم.
وينبغي التنبيه على أمور الاول إنه ربما يتوهم بعض: (أن الخلاف في إعتبار ظواهر الكتاب قليل الجدوى، إذ ليست آية متعلقة بالفروع أو الاصول إلا ورد في بيانها أو في الحكم الموافق لها خبر أو أخبار كثيرة، بل إنعقد الاجماع على أكثرها.
مع أن جل آيات الاصول والفروع، بل كلها، مما تعلق بالحكم فيها بأمور مجملة لا يمكن العمل بها إلا بعد أخد تفصيلها من الاخبار)، إنتهى.
" النراقي، مناهج الاحكام، ص ١٥٨ ".
أقول: ولعله قصر نظره على الايات الواردة في العبادات، فإن أغلبها من قبيل ما ذكره، وإلا فالاطلاقات الواردة في المعاملات مما يتمسك بها في الفروع الغير المنصوصة أو المنصوصة بالنصوص المتكافئة كثيرة جدا.
مثل: (أوفوا بالعقود)، و (أحل الله البيع)، و (تجارة عن تراض)، و (فرهان مقبوضة)، و (لا تؤتوا السفاء أموالكم)، و (لا تقربوا مال اليتيم)، و (أحل لكم ما وراء ذلكم)، و (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا)، و (لولا نفر من كل فرقة)، و (فاسألوا أهل الذكر)، و (عبدا مملوكا لا يقدر على شي)، و (ما على المحسنين من سبيل)، وغير ذلك مما لا يحصى.
بل وفي العبادات أيضا كثيرة، مثل قوله: (إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام).
وآيات التيمم، والوضوء، والغسل.
وهذا العمومات، وإن ورد فيها أخبار في الجملة، إلا أنه ليس كل فرع مما يتمسك فيه بالاية ورد فيه خبر سليم عن المكافئ، فلاحظ وتتبع.
الثاني: إنه إذا إختلف القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في المؤدى، كما في قوله تعالى: (حتى
يطهرن)، حيث قرء بالتشديد من المتطهر الظاهر في الاغتسال، وبالتخفيف من الطهارة الظاهرة في النقاء عن الحيض.
فلا يخلو: إما أن نقول بتواتر القراءات كلها، كما هو المشهور، خصوصا في ما كان الاختلاف في المادة، وإما أن لا نقول، كما هو مذهب جماعة.
فعلى الاول، فهما بمنزلة آيتين تعارضتا، لا بد من الجمع بينهما بحمل الظاهر على النص أو على الاظهر، ومع التكافؤ لا بد من الحكم بالتوقف والرجوع إلى غيرهما.
وعلى الثاني، فإن ثبت جواز الاستدلال بكل قراءة، كما ثبت بالاجماع جواز القراءة بكل قراءة، كان الحكم كما تقدم.
وإلا فلا بد من التوقف في محل التعارض والرجوع إلى القواعد، مع عدم المرجح أو مطلقا بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا، كما هو الظاهر.
فيحكم بإستصحاب الحرمة قبل الاغتسال، إذ لم يثبت تواتر التخفيف، أو بالجواز بناء على عموم قوله تعالى: (فأتوا حرثكم أنى شئتم)، من حيث الزمان، خرج منه أيام الحيض على الوجهين في كون المقام من إستصحاب حكم المخصص أو العمل بالعموم الزماني.
الثالث: إن وقوع التحريف في القرآن، على القول به، لايمنع من التمسك بالظواهر، لعدم العلم الاجمالي بإختلال الظواهر بذلك، مع أنه لو علم لكان من قبيل الشبهة الغير المحصورة.
مع أنه لو كان من قبيل الشبهة المحصورة، أمكن القول بعدم قدحه، لاحتمال كون الظاهر المصروف عن ظاهره من الظواهر الغير المتعلقة بالاحكام الشرعية العملية التي أمرنا بالرجوع فيها إلى ظاهر الكتاب، فافهم.
الرابع: قد يتوهم: (أن وجوب العمل بظواهر الكتاب بالاجماع مستلزم لعدم جواز العمل بظاهره، لان من تلك الظواهر ظاهر الايات الناهية عن العمل بالظن مطلقا حتى ظواهر الكتاب).
وفيه: أن فرض وجود الدليل على حجية الظواهر موجب لعدم ظهور الايات الناهية في حرمة العمل بالظواهر، مع أن ظواهر الايات الناهية لو نهضت للمنع عن ظواهر الكتاب لمنعت عن حجية أنفسها، إلا أن يقال إنها لا تشمل أنفسها.
فتأمل.
وبإزاء هذا التوهم توهم: (أن خروج ظواهر الكتاب عن الايات الناهية ليس من باب التخصيص، بل من باب التخصص، لان وجود القاطع على حجيتها يخرجها عن غير العلم إلى العلم).
وفيه: ما لا يخفى.
وأما التفصيل الاخر فهو الذي يظهر من صاحب القوانين، قدس سره، في آخر مسألة حجية الكتاب وفي أول مسألة الاجتهاد والتقليد.
وهو الفرق بين من قصد إفهامه بالكلام، فالظواهر حجة بالنسبة إليه من باب الظن الخاص، سواء كان مخاطبا، كما في الخطابات الشفاهية، أم لا، كما في الناظر في الكتب المصنفة، لرجوع كل من ينظر إليها، وبين من لم يقصد إفهامه بالخطاب، كأمثالنا بالنسبة إلى أخبار الائمة الصادرة عنهم في مقام الجواب عن سؤال السائلين وبالنسبة إلى الكتاب العزيز، بناء على عدم كون خطاباته موجهة إلينا وعدم كونه من باب تأليف المصنفين.
فالظهور اللفظي ليس حجة حينئذ لنا، إلا من باب الظن المطلق الثابت حجيته عند إنسداد باب العلم.
ويمكن توجيه هذا التفصيل: بأن الظهور اللفظي ليس حجة إلا من باب الظن النوعي.
وهو كون اللفظ بنفسه لو خلي وطبعه مفيدا للظن بالمراد.
فإذا كان مقصود المتكلم من الكلام إفهام من يقصد إفهامه، فيجب عليه إلقاء الكلام على وجه لا يقع المخاطب معه في خلاف المراد، بحيث لو فرض وقوعه في خلاف المقصود، كان إما لغفلة منه في الالتفات إلى ما اكتنف به الكلام الملقى إليه، وإنما لغفلة من المتكلم في إلقاء الكلام على وجه يفي بالمراد.
ومعلوم أن إحتمال الغفلة من المتكلم أو السامع إحتمال مرجوح في نفسه مع إنعقاد الاجماع من العقلاء والعلماء على عدم الاعتناء بإحتمال الغفلة في جميع أمور العقلاء، أقوالهم وأفعالهم.
وأما إذا لم يكن الشخص مقصودا بالافهام، فوقوعه في خلاف المقصود لا ينحصر سببه في الغفلة.
فإنا إذا لم نجد في آية أو رواية ما يكون صارفا عن ظاهرها واحتملنا ان يكون المخاطب قد فهم المراد بقرينة قد خفيت علينا، فلا يكون هذا الاحتمال لاجل غفلة من المتكلم أو منا، إذ لا يجب على المتكلم إلا نصب القرينة لمن قصد إفهامه، مع أن عدم تحقق الغفلة من المتكلم في محل
الكلام مفروض لكونه معصوما.
وليس إختفاء القرينة علينا مسببا عن غفلتنا عنها، بل لدواعي الاختفاء الخارجة عن مدخلية المتكلم ومن ألقي إليه الكلام.
فليس هنا شئ يوجب بنفسه الظن بالمراد، حتى لو فرضنا الفحص.
فإحتمال وجود القرينة حين الخطاب وإختفائه علينا ليس هنا ما يوجب مرجوحيته حتى لو تفحصنا عنها ولم نجدها.
إذ لا يحكم العادة، ولو ظنا، بأنها لو كانت لظفرنا بها، إذ كثير من الامور قد إختفت علينا.
بل لا يبعد دعوى العلم بأن ما إختفى علينا من الاخبار والقرائن أكثر مما ظفرنا بها، مع أنا لو سلمنا حصول الظن بإنتفاء القرائن المتصلة، لكن القرائن الحاليه وما اعتمد عليه المتلكم من الامور العقلية أو النقلية الكلية أو الجزئية المعلومة عند المخاطب الصارفة لظاهر الكلام ليست مما يحصل الظن بانتفائها بعد البحث والفحص.
ولو فرض حصول الظن من الخارج بإرادة الظاهر من الكلام لم يكن ذلك ظنا مستندا إلى الكلام، كما نبهنا عليه في أول المبحث.
وبالجملة، فظواهر الالفاظ حجة، بمعنى عدم الاعتناء بإحتمال إرادة خلافها، إذا كان منشأ ذلك الاحتمال غفلة المتكلم في كيفية الافادة أو المخاطب في كيفية الاستفادة، لان إحتمال الغفلة مما هو مرجوح في نفسه ومتفق على عدم الاعتناء به في جميع الامور دون ما إذا كان الاحتمال مسببا عن إختفاء أمور لم تجر العادة القطعية أو الظنية بأنها لو كانت لوصلت إلينا.
ومن هنا يظهر: أن ما ذكرنا سابقا، من إتفاق العقلاء والعلماء على العمل بظواهر الكلام في الدعاوى والاقارير والشهادات والوصايا والمكاتبات، لا ينفع في رد هذا الفصيل، إلا أن يثبت كون أصالة عدم القرينة حجة من باب التعبد.ودون إثباتها خرط القتاد.
ودعوى: (أن الغالب إتصال القرائن، فإحتمال إعتماد المتكلم على القرينة المنفصلة مرجوح لندرته)، مردودة: بأن من المشاهد المحسوس تطرق التقييد والتخصيص إلى أكثر العمومات والاطلاقات مع عدم وجوده في الكلام.
وليس إلا لكون الاعتماد في ذلك كله على القرائن المفصلة، سواء كانت منفصلة عند الاعتماد كالقرائن العقلية والنقلية الخارجية أم كانت مقالية متصلة، لكن عرض لها الانفصال بعد ذلك، لعروض التقطيع للاخبار أو حصول التفاوت من جهة النقل بالمعنى أو غير ذلك.
فجميع ذلك مما لا يحصل الظن بأنها لو كانت لوصلت إلينا.
مع إمكان أن يقال: إنه لو حصل الظن لم يكن على إعتباره دليل خاص.
نعم، الظن الحاصل في مقابل إحتمال الغفلة الحاصلة للمخاطب أو المتكلم مما أطبق عليه العقلاء في جميع أقوالهم وأفعالهم.هذا غاية ما يمكن
من التوجيه لهذا التفصيل.
* * *
ولكن الانصاف: أنه لا فرق في العمل بالظهور اللفظي وأصالة عدم الصارف عن الظاهر بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد، فإن جميع ما دل من إجماع العلماء وأهل اللسان على حجية الظاهر بالنسبة إلى من قصد إفهامه جار فيما يقصد، لان أهل اللسان إذا نظروا إلى كلام صادر من متكلم إلى مخاطب يحكمون بإرادة ظاهره منه إذا لم يجدوا قرينة صارفة بعد الفحص في مظان وجودها، ولا يفرقون في إستخراج مرادات المتكلمين بين كونهم مقصودين بالخطاب وعدمه.
فإذا وقع المكتوب الموجه من شخص إلى شخص بيد ثالث، فلا يتأمل في إستخراج مرادات المتكلم من الخطاب المتوجه إلى المكتوب إليه.
فإذا قرضنا إشتراك هذا الثالث مع المكتوب إليه فيما أراد المولى منهم، فلا يجوز له الاعتذار في ترك الامتثال بعدم الاطلاع على مراد المولى.
وهذا واضح لمن راجع الامثلة العرفية، هذا حال أهل اللسان في الكلمات الواردة إليهم.
وأما العلماء، فلا خلاف بينهم في الرجوع إلى أصالة الحقيقة في الالفاظ المجردة عن القرائن الموجة من متكلم إلى مخاطب، سواء كان ذلك في الاحكام الجزئية، كالوصايا الصادرة عن الموصي المعين إلى شخص معين، ثم مست الحاجة إلى العمل بها مع فقد الموصى إليه، فإن العلماء لا يتأملون في الافتاء بوجوب العمل بظاهر ذلك الكلام الموجه إلى الموصى إليه المقصود وكذا في الاقارير، أم كان في الاحكام الكلية، كالاخبار الصادرة عن الائمة، عليهم السلام، مع كون المقصود منها تفهيم مخاطبهم لا غير، فإنه لم يتأمل أحد من العلماء في إستفادة الاحكام من ظواهرها معتذرا بعدم الدليل على حجية أصالة عدم القرينة بالنسبة إلى غير المخاطب ومن قصد إفهامه.
ودعوى: (كون ذلك منهم للبناء على كون الاخبار الصادرة عنهم، عليهم السلام، من قبيل تأليف المصنفين)، واضحة الفساد.
مع أنها لو صحت لجرت في الكتاب العزيز، فإنه أولى بأن يكون من هذا القبيل، فترتفع ثمرة التفصيل المذكور، لان المفصل معترف بأن ظاهر الكلام الذي هو من قبيل تأليف المؤلفين حجة بالخصوص، لا لدخوله في مطلق الظن.
وإنما كلامه في إعتبار ظهور الكلام الموجه إلى مخاطب خاص بالنسبة إلى غيره.
والحاصل: أن القطع حاصل لكل متتبع في طريقة فقهاء المسلمين بأنهم يعملون بظواهر الاخبار من دون إبتناء ذلك على حجية الظن المطلق الثابتة بدليل الانسداد، بل يعمل بها من يدعي الانفتاح وينكر العمل بأخبار الآحاد، مدعيا كون معظم الفقه معلوما بالاجماع والاخبار المتواترة.
ويدل على ذلك أيضا سيرة أصحاب الائمة، عليهم السلام، فإنهم كانوا يعملون بظواهر الاخبار الواردة إليهم من الائمة الماضين، عليهم السلام، كما كانوا يعملون بظواهر الاقوال التي سمعوها من إئمتهم، عليهم السلام، لا يفرقون بينهما إلا بالفحص وعدمه، كما سيأتي.
والحاصل: أن الفرق في حجية أصالة الحقيقة وعدم القرينة بين المخاطب وغيره مخالف للسيرة القطعية من العلماء وأصحاب الائمة عليهم السلام.
هذا كله، مع أن التوجيه المذكور لذلك التفصيل، لابتنائه على الفرق بين أصالة عدم الغفلة والخطأ في فهم المراد وبين مطلق أصالة عدم القرينة، يوجب عدم كون ظواهر الكتاب من الظنون المخصوصة، وإن قلنا بشمول الخطاب للغائبين، لعدم جريان أصالة عدم الغفلة في حقهم مطلقا.
فما ذكره من إبتناء كون ظواهر الكتاب ظنونا مخصوصة على شمول الخطاب للغائبين غير سديد، لان الظن المخصوص إن كان هو الحاصل من المشافهة الناشي عن ظن عدم الغفلة والخطأ، فلا يجري في حق الغائبين، وإن قلنا بشمول الخطاب لهم، وإن كان هو الحاصل من أصالة عدم القرينة فهو جار في الغائبين وإن لم يشملهم الخطاب.
ومما يمكن أن يستدل به أيضا زيادة على ما مر من إشتراك أدلة حجية الظواهر من إجماعي العلماء وأهل اللسان ما ورد في الاخبار المتواترة معنى، من الامر بالرجوع إلى الكتاب وعرض الاخبار عليه، فإن هذه الظواهر المتواترة حجة للمشافهين بها، فيشترك غير المشافهين، فيتم المطلوب، كما لا يخفى.
ومما ذكرنا تعرف النظر فيما ذكره المحقق القمي، رحمه الله، بعدما ذكر من عدم حجية ظواهر الكتاب بالنسبة إلينا بالخصوص، بقوله: (فإن قلت: إن أخبار الثقلين تدل على كون ظاهر الكتاب حجة لغير المشافهين بالخصوص.
فأجاب عنه: بأن رواية الثقلين ظاهرة في ذلك، لاحتمال كون المراد التمسك بالكتاب بعد ورود تفسيره عن الائمة، عليهم السلام، كما يقوله الاخباريون.
وحجية ظاهر رواية الثقلين بالنسبة إلينا مصادرة، إذ لا فرق بين ظواهر الكتاب والسنة في حق غير المشافهين بها).
وتوضيح النظر: أن العمدة في حجية ظواهر الكتاب غير خبر الثقلين من الاخبار المتواترة الآمرة
بإستنباط الاحكام من ظواهر الكتاب.
وهذه الاخبار تفيد القطع بعدم إرادة الاستدلال بظواهر الكتاب بعد ورود تفسيرها عن الائمة، عليهم السلام، وليست ظاهرة في ذلك حتى يكون التمسك بظاهرها لغير المشافهين بها مصادرة.
وأما خبر الثقلين، فيمكن منع ظهوره إلا في وجوب إطاعتهما وحرمة مخالفتهما، وليس في مقام إعتبار الظن الحاصل بهما في تشخيص الاطاعة والمعصية، فافهم.
ثم إن لصاحب المعالم، رحمه الله، في هذا المقام كلاما يحتمل التفصيل المتقدم، لا بأس بالاشارة إليه.
قال: - في الدليل الرابع من أدلة حجية خبر الواحد، بعد ذكر إنسداد باب العلم في غير الضروري من الاحكام، لفقد الاجماع والسنة المتواترة ووضوح كون أصل البراءة لا يفيد غير الظن وكون الكتاب ظني الدلالة - ما لفظه: لا يقال: إن الحكم المستفاد من ظواهر مقطوع لا مظنون، وذلك بضميمة مقدمة خارجية، وهي قبح خطاب الحكيم بما له ظاهر وهو يريد خلافه من غير دلالة تصرف عن ذلك الظاهر.
سلمنا، ولكن ذلك ظن مخصوص، فهو من قبيل الشهادة لا يعدل عنه إلى غيره إلا بدليل.
لانا نقول: أحكام الكتاب كلها من قبيل خطاب المشافهة.
وقد مر أنه مخصوص بالموجودين في زمن الخطاب وأن ثبوت حكمه في حق من تأخر إنما هو بالاجماع وقضاء الضرورة بإشتراك التكليف بين الكل.
وحينئذ فمن الجائز أن يكون قد إقترن ببعض تلك الظواهر ما يدلهم على إرادة خلافها.
وقد وقع ذلك في مواضع علمناها بالاجماع ونحوه، فيحتمل الاعتماد في تعريفنا لسائرها على الامارات المفيدة للظن القوي، وخبر الواحد من جملتها.
ومع قيام هذا الاحتمال ينفى القطع بالحكم.
ويستوي حينئذ الظن المستفاد من ظاهر الكتاب والحاصل من غيره بالنظر إلى إناطة التكليف به، لابتناء الفرق بينهما على كون الخطاب متوجها إلينا، وقد تبين خلافه، ولظهور إختصاص الاجماع والضرورة الدالين على المشاركة في التكليف المستفاد من ظاهر الكتاب بغير صورة وجود الخبر الجامع للشرائط الاتية المفيدة للظن)، إنتهى كلامه.
ولا يخفى: أن في كلامه، قدس سره، على إجماله وإشتباه المراد منه كما يظهر من المحشين مواقع النظر والتأمل.
ثم إنك قد عرفت: أن مناط الحجية والاعتبار في دلالة الالفاظ هو الظهور العرفي، وهو كون الكلام بحيث يحمل عرفا على ذلك المعنى ولو بواسطة القرائن المقامية المكتنفة بالكلام.
فلا فرق بين إفادته الظن بالمراد وعدمها، ولا بين وجود الظن الغير المعتبر على خلافه وعدمه، لان ما ذكرنا من الحجه على العمل بها جار في جميع الصور المذكورة.
وما ربما يظهر من العلماء من التوقف في العمل بالخبر الصحيح المخالف لفتوى المشهور أو طرحه مع إعترافهم بعدم حجية الشهرة - فليس من جهة مزاحمة الشهرة لدلالة الخبر الصحيح من عموم أو إطلاق، بل من جهة مزاحمتها للخبر من حيث الصدور، بناء على أن ما دل من الدليل على حجية الخبر الواحد من حيث السند لا يشمل المخالف للمشهور، ولذا لايتأملون في العمل بظواهر الكتاب والسنة المتواترة الصدور إذا عارضها الشهرة.
فالتأمل في الخبر المخالف للمشهور إنما هو إذا خالفت الشهرة نفس الخبر، لا عمومه أو إطلاقه.
فلا يتأملون في عمومه إذا كانت الشهرة على التخصيص.
نعم، ربما يجري على لسان بعض متأخري المتأخرين من المعاصرين عدم الدليل على حجية الظواهر إذا لم تفد الظن او إذا حصل الظن الغير المعتبر على خلافها.
لكن الانصاف: أنه مخالف لطريقة أرباب اللسان والعلماء في كل زمان، ولذا عد بعض الاخباريين، كالاصوليين، إستصحاب حكم العام والمطلق حتى يثبت المخصص والمقيد من الاستصحابات المجمع عليها.
وهذا وإن لم يرجع إلى الاستصحاب المصطلح إلا بالتوجيه، إلا أن الغرض من الاستشهاد به بيان كون هذه القاعدة إجماعية.
وربما فصل بعض من المعاصرين تفصيلا يرجع حاصله إلى: (أن الكلام إن كان مقرونا بحال أو مقال يصلح أن يكون صارفا عن المعنى الحقيقي فلا يتمسك فيه بأصالة الحقيقة، وإن كان الشك في أصل وجود الصارف أو كان هنا أمر منفصل يصلح لكونه صارفا، فيعمل على أصالة الحقيقة).
وهذا تفصيل حسن متين، لكنه تفصيل في العمل بأصالة الحقيقة عند الشك في الصارف، لا
في حجية الظهور اللفظي، ومرجعة إلى تعيين الظهور العرفي وتمييزه عن موارد الاجمال، فإن اللفظ في القسم الاول يخرج عن الظهور إلى الاجمال بشهادة العرف.
ولذا توقف جماعة في المجاز المشهور والعام المتعقب بضمير يرجع إلى بعض أفراده والجمل المتعددة المتعقبة للاستثناء والامر والنهي الواردين في مظان الحظر أو الايجاب، إلى غير ذلك مما احتف اللفظ بحال او مقال يصلح لكونه صارفا.
ولم يتوقف أحد في عام بمجرد إحتمال دليل منفصل يحتمل كونه مخصصا له، بل ربما يعكسون الامر فيحكمون بنفي ذلك الاحتمال وإرتفاع الاجمال لاجل ظهور العام.
ولذا لو قال المولى: أكرم العلماء، ثم ورد قول آخر من المولى إنه لا تكرم زيدا، واشترك زيد بين عالم وجاهل، فلا يرفع اليد عن العموم بمجرد الاحتمال، بل يرفعون الاجمال بواسطة العموم، فيحكمون بإرادة زيد الجاهل من النهي.
وبإزاء التفصيل المذكور تفصيل آخر ضعيف، وهو: (أن إحتمال إرادة خلاف مقتضى اللفظ إن حصل من أمارة غير معتبرة فلا يصح رفع اليد عن الحقيقة، وإن حصل من دليل معتبر فلا يعمل بأصالة الحقيقة.
ومثل له بما إذا ورد في السنة المتواترة عام وورد فيها أيضا خطاب مجمل يوجب الاجمال في ذلك العام ولا يوجب الظن بالواقع.
قال -: فلا دليل على لزوم العمل بالاصل تعبدا.
ثم قال -: ولا يمكن دعوى الاجماع على لزوم العمل بأصالة الحقيقة تعبدا، فإن أكثر المحققين توقفوا في ما إذا تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح) إنتهى.
ووجه ضعفه يظهر مما ذكر، فإن التوقف في ظاهر خطاب لاجل إجمال خطاب آخر محتمل لكونه معارضا، مما لم يعهد من أحد من العلماء، بل لا يبعد ما تقدم من حمل المجمل في أحد الخطابين على المبين في الخطاب الاخر.
وأما قياس ذلك على مسألة تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح، فعلم فساده مما ذكرنا في التفصيل المتقدم، من أن الكلام المكتنف بما يصلح أن يكون صارفا قد إعتمد عليه المتكلم في إرادة خلاف الحقيقة لا يعد من الظواهر، بل من المجملات.
وكذلك المتعقب بلفظ يصلح للصارفية كالعام المتعقب بالضمير وشبهه مما تقدم.
القسم الثاني وهو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر
كتشخيص أن اللفظ المفرد الفلاني، كلفظ الصعيد أو صيغة إفعل، أو أن المركب الفلاني، كالجملة الشرطية، ظاهر بحكم الوضع في المعنى الفلاني، وأن الامر الواقع عقيب الحظر ظاهر بقرينة وقوعه في مقام رفع الحظر - في مجرد رفع الحظر دون الالزام، والظن الحاصل هنا يرجع إلى الظن بالوضع اللغوي أو الانفهام العرفي، والاوفق بالقواعد عدم حجية الظن هنا، لان الثابت المتيقن هي حجية الظواهر.
وأما حجية الظن في أن هذا ظاهر، فلا دليل عليه، عدا وجوه ذكروها في إثبات جزئي من هذه المسألة.
وهي حجية قول اللغويين في الاوضاع.
فإن المشهور كونه من الظنون الخاصة التي ثبت حجيتها مع قطع النظر عن إنسداد باب العلم في الاحكام الشرعية وإن كانت الحكمة في إعتبارها إنسداد باب العلم في غالب مواردها، فإن الظاهر أن حكمة إعتبار أكثر الظنون الخاصة، كأصالة الحقيقة التقدم ذكرها وغيرها، إنسداد باب العلم في غالب مواردها من العرفيات والشرعيات.
والمراد بالظن المطلق ما ثبت إعتباره من أجل إنسداد باب العلم بخصوص الاحكام الشرعية، وبالظن الخاص ما ثبت إعتباره، لا لاجل الاضطرار إلى إعتبار مطلق الظن بعد تعذر العلم.
* * *
وكيف كان، فاستدلوا على إعتبار قول اللغويين بإتفاق العلماء بل جميع العقلاء على الرجوع إليهم في إستعلام اللغات والاستشهاد بأقوالهم في مقام الاحتجاج، ولم ينكر ذلك أحد على أحد.
وقد حكي عن السيد في بعض كلماته دعوى الاجماع على ذلك، بل ظاهر كلامه المحكي إتفاق المسلمين.
قال الفاضل السبزواري، فيما حكي عنه، في هذا المقام، ما هذا لفظه: (صحة المراجعة إلى أصحاب الصناعات البارزين في صنعتهم البارعين في فنهم فيما إختص بصناعتهم، مما إتفق عليه العقلاء في كل عصر وزمان)، إنتهى.
وفيه: أن المتيقن من هذا الاتفاق هو الرجوع إليهم مع إجتماع شرائط الشهادة من العدد و العدالة ونحو ذلك، لا مطلقا.
ألا ترى أن أكثر علمائنا على إعتبار العدالة فيمن يرجع إليه من أهل الرجال، بل وبعضهم على إعتبار العدد، والظاهر إتفاقهم على إشتراط التعدد والعدالة في أهل الخبرة في مسألة التقويم وغيرها.
هذا مع أنه لا يعرف الحقيقة عن المجاز بمجرد قول اللغوي، كما إعترف به المستدل في بعض كلماته، فلا ينفع في تشخيص الظواهر.
فالانصاف: أن الرجوع إلى أهل اللغة مع عدم إجتماع شروط الشهادة: إما في مقامات يحصل العلم فيها بالمستعمل فيه من مجرد ذكر لغوي واحد أو أزيد له على وجه يعلم كونه من المسلمات عند أهل اللغة، كما قد يحصل العلم بالمسألة الفقهية من إرسال جماعة لها إرسال المسلمات، وإما في مقامات يتسامح فيها، لعدم التكليف الشرعي بتحصيل العلم بالمعنى اللغوي، كما إذا أريد تفسير خطبة أو رواية لا تتعلق بتكليف شرعي، وإما في مقام إنسد فيه طريق العلم ولا بد من العمل، فيعمل بالظن بالحكم الشرعي المستند بقول أهل اللغة.
ولا يتوهم: (أن طرح قول اللغوي الغير المفيد للعلم في ألفاظ الكتاب والسنة مستلزم لانسداد طريق الاستنباط في غالب الاحكام.
لاندفاع ذلك: بأن أكثر مواد اللغات إلا ما شذ وندر - كلفظ الصعيد ونحوه - معلوم من العرف و اللغة، كما لا يخفى.
والمتبع في الهيئآت هي القواعد العربية المستفادة من الاستقراء القطعي، وإتفاق أهل العربية أو التبادر بضميمة أصالة عدم القرنية، فإنه قد يثبت به الوضع الاصلي الموجود في الحقائق، كما في صيغه (إفعل) أو الجملة الشرطية أو الوصفية.
ومن هنا يتمسكون في إثبات مفهوم الوصف بفهم أبي عبيدة في حديث: (لي الواجد)، و نحوه غيره من موارد الاستشهاد - بفهم أهل اللسان.
وقد يثبت به الوضع بالمعنى الاعم الثابت في المجازات المكتنفة بالقرائن المقامية، كما يدعى أن الامر عقيب الحظر بنفسه مجردا عن القرينة يتبادر
منه مجرد رفع الحظر دون الايجاب والالزام.
وإحتمال كونه لاجل قرينة خاصة يدفع بالاصل، فيثبت به كونه لاجل القرينة العامة، وهي الوقوع في مقام رفع الحظر، فيثبت بذلك ظهور ثانوي لصيغة (إفعل) بواسطة القرينة الكلية.
وبالجملة، فالحاجة إلى قول اللغوي الذي لا يحصل العلم بقوله، لقلة مواردها، لا تصلح سببا للحكم بإعتباره لاجل الحاجة.
نعم سيجئ أن كل من عمل بالظن في مطلق الاحكام الشرعية الفرعية يلزمه العمل بالحكم الناشي من الظن بقول اللغوي، لكنه لا يحتاج إلى دعوى إنسداد باب العلم في اللغات، بل العبرة عنده بإنسداد باب العلم في معظم الاحكام.
فإنه يوجب الرجوع إلى الظن بالحكم الحاصل من الظن باللغة وإن فرض إنفتاح باب العلم فيما عدا هذا المورد من اللغات، وسيتضح هذا زيادة على هذا إن شاء الله، هذا.
ولكن الانصاف: أن مورد الحاجة إلى قول اللغويين أكثر من أن يحصى في تفاصيل المعاني بحيث يفهم دخول الافراد المشكوكة أو خروجها وإن كان المعنى في الجملة معلوما من دون مراجعة قول اللغوي، كما في ألفاظ الوطن، والمفازة، والتمر، والفاكهة، والكنز، والمعدن، والغوص، وغير ذلك من متعلقات الاحكام مما لا يحصى، وإن لم تكن الكثرة بحيث يوجب التوقف فيها محذورا.
ولعل هذا المقدار مع الاتفاقات المستفيضة كاف في المطلب، فتأمل.
ومن جملة الظنون الخارجة عن الاصل الاجماع المنقول بخبر الواحد عند كثير ممن يقول بإعتبار الخبر بالخصوص، نظرا إلى أنه أفراده، فيشمله أدلته، والمقصود من ذكره هنا، مقدما على بيان الحال في الاخبار، هو التعرض للملازمة بين حجية الخبر وحجيته، فنقول: إن ظاهر أكثر القائلين بإعتباره بالخصوص أن الدليل عليه هو الدليل على حجية خبر العادل.
فهو عندهم كخبر صحيح عالي السند، لان مدعي الاجماع يحكي مدلوله ويرويه عن الامام، عليه السلام، بلا واسطة.
ويدخل الاجماع ما يدخل لاخبر من الاقسام ويلحقه مايلحقه من الاحكام.
والذي يقوى في النظر هو عدم الملازمة بين حجية الخبر وحجية الاجماع المنقول، وتوضيح ذلك يحصل بتقديم أمرين: [ الامر ] الاول إن الادلة الخاصة التي أقاموها على حجية خبر العادل لا تدل إلا على حجية الاخبار عن حس، لان العمدة من تلك الادلة هو الاتفاق الحاصل من عمل القدماء وأصحاب الائمة، عليهم السلام، ومعلوم عدم شمولها إلا للرواية المصطلحة.وكذلك الاخبار الواردة في العمل بالروايات.
اللهم إلا أن يدعى أن المناط في وجوب العمل بالروايات هو كشفها عن الحكم الصادر عن المعصوم.
ولا يعتبر في ذلك حكاية ألفاظ الامام، عليه السلام، ولذا يجوز النقل بالمعنى.
فإذا كان المناط كشف الروايات عن صدور معناها عن الامام، عليه السلام، ولو بلفظ آخر
والمفروض أن حكاية الاجماع أيضا حكاية حكم صادر عن المعصوم، عليه السلام، بهذه العبارة التي هي معقد الاجماع أو بعبارة أخرى - وجب العمل به.
لكن هذا المناط لو ثبت دل على حجية الشهرة بل فتوى الفقيه إذا كشف عن صدور الحكم بعبارة الفتوى أو بعبارة غيرها.
كما عمل بفتاوى علي بن بابويه، قدس سره، لتنزيل فتواه منزلة روايته، بل على حجية مطلق الظن بالحكم الصادر عن الامام، عليه السلام، وسيجئ توضيح الحال إن شاء الله.
وأما الايات، فالعمدة فيها من حيث وضوح الدلالة هي آية النبأ.
وهي إنما تدل على وجوب قبول خبر العادل دون خبر الفاسق.
والظاهر منها - بقرينة التفصيل بين العادل حين الاخبار والفاسق، وبقرينة تعليل إختصاص التبين بخبر الفاسق بقيام إحتمال الوقوع في الندم إحتمالا مساويا، لان الفاسق لا رادع له عن الكذب هو عدم الاعتناء بإحتمال تعمد كذبه، لا وجوب البناء على إصابته وعدم خطائه في حدسه، لان الفسق والعدالة حين الاخبار لا يصلح مناطا لتصويب المخبر وتخطئته بالنسبة إلى حدسه.
وكذا إحتمال الوقوع في الندم من جهة الخطأ في الحدس أمر مشترك بين العادل والفاسق، فلا يصلح لتعليل الفرق به.
فعلمنا من ذلك أن المقصود من الاية إرادة نفي إحتمال تعمد الكذب عن العادل حين الاخبار دون الفاسق، لان هذا هو الذي يصلح لاناطته بالفسق والعدالة حين الاخبار.
ومنه تبين عدم دلالة الاية على قبول الشهادة الحدسية إذا قلنا بدلالة الاية على إعتبار شهادة العدل.
فان قلت: إن مجرد دلالة الاية على ما ذكر لا يوجب قبول الخبر لبقاء إحتمال خطأ العادل فيما أخبر وإن لم يتعمد الكذب، فيجب التبين في خبر العادل أيضا، لاحتمال خطائه وسهوه.
وهو خلاف الاية المفصلة بين العادل والفاسق.
غاية الامر وجوبه في خبر الفاسق من جهتين وفي العادل من جهة واحدة.
قلت: إذا ثبت بالاية عدم جواز الاعتناء بإحتمال تعمد كذبه ينفى إحتمال خطائه وغفلته و إشتباهه بأصالة عدم الخطأ في الحس.وهذا أصل عليه إطباق العقلاء والعلماء في جميع الموارد.
نعم لو كان المخبر ممن يكثر عليه الخطأ والاشتباه لم يعبأ بخبره، لعدم جريان أصالة عدم الخطأ والاشتباه.
ولذا يعتبرون في الشاهد والراوي الضبط، وإن كان ربما يتوهم الجاهل ثبوت ذلك من الاجماع.
إلا أن المنصف يشهد بأن إعتبار هذا في جميع موارده ليس لدليل خارجي مخصص لعموم آية
النبأ ونحوها مما دل على وجوب قبول قول العادل، بل لما ذكرنا من أن المراد بوجوب قبول قول العادل رفع التهمة عنه من جهة إحتمال تعمده الكذب، لا تصويبه وعدم تخطئته أو غفلته.
ويؤيد ما ذكرنا أنه لم يستدل أحد من العلماء على حجية فتوى الفقيه على العامي بآية النبأ، مع إستدلالهم عليها بآيتي النفر السؤال.
والظاهر أن ما ذكرنا من عدم دلالة الاية وأمثالها من أدلة قبول قول العادل على وجوب تصويبه في الاعتقاد - هو الوجه فيما ذهب إليه المعظم، بل أطبقوا عليه، كما في الرياض، من عدم إعتبار الشهادة في المحسوسات إذا لم تستند إلى الحس وإن علله في الرياض بما لا يخلو عن نظر، من أن الشهاده من الشهود وهو الحضور.
فالحس مأخوذ في مفهومها.
والحاصل: أنه لا ينبغي الاشكال في أن الاخبار عن حدس وإجتهاد ونظر ليس حجة إلا على من وجب عليه تقليد المخبر في الاحكام الشرعية وأن الاية ليست عامة لكل خبر ودعوى، خرج ما خرج.
فإن قلت: فعلى هذا إذا أخبر الفاسق بخبر يعلم بعدم تعمده للكذب فيه تقبل شهادته فيه، لان إحتمال تعمده للكذب منتف بالفرض، وإحتمال غفلته وخطائه منفي بالاصل المجمع عليه، مع أنشهادته مردودة إجماعا.
قلت: ليس المراد مما ذكرنا عدم قابلية العدالة والفسق لاناطة الحكم بهما وجودا وعدما تعبدا، كما في الشهادة والفتوى ونحوهما.
بل المراد أن الاية المذكورة لا تدل إلا على مانعية الفسق من حيث قيام إحتمال تعمد الكذب معه، فيكون مفهومها عدم المانع في العادل من هذه الجهة، فلا يدل على وجوب قبول خبر العادل إذا لم يمكن نفي خطائه بأصالة عدم الخطأ المختصة بالاخبار الحسية.
فالاية لا تدل أيضا على إشتراط العدالة ومانعية الفسق في صورة العلم بعدم تعمد الكذب، بل لا بد له من دليل آخر، فتأمل.
الامر الثاني أن الاجماع في مصطلح الخاصة بل العامة، الذين هم الاصل له وهو الاصل لهم، هو إتفاق جميع العلماء في عصر، كما ينادي بذلك تعريفات كثير من الفريقين.
قال في التهذيب: (الاجماع هو إتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله
عليه وآله).
وقال صاحب غاية البادي في شرح المبادي، الذي هو أحد علمائنا المعاصرين للعلامة، قدس سره: (الاجماع في إصطلاح فقهاء أهل البيت، عليهم السلام، هو إتفاق أمة محمد، صلى الله عليه وآله، على وجه يشتمل على قول المعصوم)، إنتهى.
وقال في المعالم: (الاجماع في الاصطلاح إتفاق خاص، وهو إتفاق من يعتبر قوله من الامة)، إنتى.
وكذا غيرها من العبارات المصرحة بذلك في تعريف الاجماع وغيرها من المقامات، كما تراهم يعتذرون كثيرا عن وجود المخالف بإنقراض عصره.
ثم إنه لما كان وجه حجية الاجماع عند الامامية إشتماله على قول الامام، عليه السلام، كانت الحجية دائرة مدار وجوده، عليه السلام، في كل جماعة هو أحدهم، ولذا قال السيد المرتضى: (إذا كان علة كون الاجماع حجة كون الامام فيهم، فكل جماعة كثرت أو قلت، كان قول الامام في أقوالها، فإجماعها حجة، وإن خلاف الواحد والاثنين إذا كان الامام أحدهما قطعا أو تجويزا يقتضي عدم الاعتداد بقول الباقين وإن كثر، وإن الاجماع بعد الخلاف كالمبتدأ في الحجيه)، إنتهى.
وقال المحقق في المعتبر، بعد إناطة حجية الاجماع بدخول قول الامام عليه السلام: (إنه لو خلا المائة من فقهائنا من قوله لم يكن قولهم حجة، ولو حصل في إثنين كان قولهما حجة)، إنتهى.
وقال العلامة، رحمه الله، بعد قوله إن الاجماع عندنا حجة لاشتماله على قول المعصوم -: (وكل جماعة قلت أو كثرت كان قول الامام عليه السلام في جملة أقوالها فإجماعها حجة لاجله، لا لاجل الاجماع)، إنتهى.
هذا، ولكن لا يلزم من كونه حجة تسميته إجماعا في الاصطلاح، كما أنه ليس كل خبر جماعة يفيد العلم متواترا في الاصطلاح.
وأما ما إشتهر بينهم من أنه لا يقدح خروج معلوم النسب، واحدا أو أكثر، فالمراد أنه لا يقدح في حجية إتفاق الباقي، لا في تسميته إجماعا، كما علم من فرض المحقق،
قدس سره، الامام عليه السلام في إثنين.
نعم، ظاهر كلمات جماعة يوهم تسميته إجماعا في الاصطلاح حيث تراهم يدعون الاجماع في مسألة، ثم يعتذرون عن وجود المخالف بأنه معلوم النسب.
لكن التأمل الصادق يشهد بأن الغرض الاعتذار عن قدح المخالف في الحجية لا في التسمية.
نعم يمكن أن يقال: إنهم قد تسامحوا في إطلاق الاجماع على إتفاق الجماعة التي علم دخول الامام عليه السلام فيها، لوجود مناط الحجية فيه وكون وجود المخالف غير مؤثر شيئا، وقد شاع هذا التسامح بحث كاد أن ينقلب إصطلاح الخاصة عما وافق إصطلاح العامة إلى ما يعم إتفاق طائفة من الامامية، كما يعرف من أدنى تتبع لموارد الاستدلال.
بل إطلاق لفظ الاجماع بقول مطلق على إجماع الامامية فقط، مع أنهم بعض الامة لا كلهم، ليس إلا لاجل المسامحة، من جهة أن وجود المخالف كعدمه من حيث مناط الحجية.
وعلى أي تقدير فظاهر إطلاقهم إرادة دخول قول الامام، عليه السلام، في أقوال المجمعين بحيث يكون دلالته عليه بالتضمن.
فيكون الاخبار عن الاجماع إخبارا عن قول الامام عليه السلام.
وهذا هو الذي يدل عليه كلام المفيد والمرتضى وإبن زهرة والمحقق والعلامة والشهيدين ومن تأخر عنهم.
وأما إتفاق من عدا الامام عليه السلام - بحيث يكشف عن صدور الحكم عن الامام، عليه السلام، بقاعدة اللطف كما عن الشيخ، رحمه الله، أو التقرير كما عن بعض المتأخرين، أو بحكم العادة القاضية بإستحالة توافقهم على الخطأ مع كمال بذل الوسع في فهم الحكم الصادر عن الامام عليه السلام - فهذا ليس إجماعا إصطلاحيا إلا أن ينضم قول الامام عليه السلام المكشوف عنه بإتفاق هؤلاء إلى أقوالهم، فيسمى المجموع إجماعا، بناء على ما تقدم من المسامحة في تسمية إتفاق جماعة مشتمل على قول الامام عليه السلم إجماعا وإن خرج عنه الكثر أو الاكثر.
فالدليل في الحقيقة هو إتفاق من عدا الامام (ع)، والمدلول الحكم الصادر عنه عليه السلام نظير كلام الامام (ع) ومعناه.
فالنكتة في التعبير عن الدليل بالاجماع - مع توقفه على ملاحظة إنضمام مذهب الامام، عليه السلام، الذي هو المدلول إلى الكاشف عنه وتسمية المجموع دليلا - هو التحفظ على ما جرت سيرة أهل الفن، من إرجاع كل دليل إلى أحد الادلة المعروفة بين الفريقين، أعني الكتاب والسنة والاجماع والعقل.
ففي إطلاق الاجماع على هذا مسامحة في مسامحة، وحاصل المسامحتين إطلاق الاجماع على إتفاق
طائفه يستحيل بحكم العادة خطأهم وعدم وصولهم إلى حكم الامام عليه السلام.
والاطلاع على تعريفات الفريقين وإستدلالات الخاصة وأكثر العامة على حجية الاجماع يوجب القطع بخروج هذا الاطلاق عن المصطلح وبنائه على المسامحة لتنزيل وجود من خرج عن هذا الاتفاق منزلة عدمه.
كما عرفت من السيد والفاضلين، قدست أسرارهم، من أن كل جماعة قلت أو كثرت علم دخول قول الامام، عليه السلام، فيهم، فإجماعهم حجة.
ويكفيك في هذا ما سيجئ من المحقق الثاني في تعليق الشرائع من: (دعوى الاجماع على أن خروج الواحد من علماء العصر قادح في إنعقاد الاجماع)، مضافا إلى ما عرفت من إطباق الفريقين على تعريف الاجماع بإتفاق الكل.
ثم إن المسامحة من الجهة الاولى أو الثانية في إطلاق لفظ الاجماع على هذا من دون قرينة لا ضير فيها، لان العبرة في الاستدلال بحصول العلم من الدليل للمستدل.
نعم لو كان نقل الاجماع المصطلح حجة عند الكل كان إخفاء القرينة في الكلام الذي هو المرجع للغير تدليسا.
أما لو لم يكن نقل الاجماع حجة أو كان نقل مطلق الدليل القطعي حجة لم يلزم تدليس أصلا.
ويظهر من ذلك ما في كلام صاحب المعالم، رحمه الله، حيث أنه بعد أن ذكر أن حجية الاجماع إنما هي لاشتماله على قول المعصوم واستنهض بكلام المحقق الذي تقدم واستجوده، قال: (والعجب من غفلة جمع من الاصحاب عن هذا الاصل وتساهلهم في دعوى الاجماع عند إحتجاجهم به للمسائل الفقهية، حتى جعلوه عبارة عن إتفاقهم جماعة من الاصحاب، فعدلوا به عن معناه الذي جرى عليه الاصطلاح من دون نصب قرينة جلية ولا دليل لهم على الحجية يعتد به) إنتهى.
وقد عرفت أن مساهلتهم وتسامحهم في محله، بعدما كان مناط حجية الاجماع الاصطلاحي موجودا في إتفاق جماعة من الاصحاب وعدم تعبيرهم عن هذا الاتفاق بغير لفظ الاجماع، لما عرفت من التحفظ على عناوين الادلة المعروفة بين الفريقين.
إذا عرفت ما ذكرنا فنقول: إن الحاكي للاتفاق قد ينقل الاجماع بقول مطلق أو مضافا إلى المسلمين أو الشيعة أو أهل الحق أو غير ذلك مما يمكن أن يراد به دخول الامام عليه السلام في المجمعين، وقد ينقله مضافا إلى من عدا الامام، عليه السلام.
كقوله: أجمع علماؤنا أو أصحابنا أو
فقهاؤنا أو فقهاء أهل البيت، عليهم السلام، فإن ظاهر ذلك من عدا الامام عليه السلام، وإن كان إرادة العموم محتملة بمقتضى المعنى اللغوي.
لكنه مرجوح، فإن أضاف الاجماع إلى من عدا الامام عليه السلم فلا إشكال في عدم حجية نقله، لانه لم ينقل حجة وإن فرض حصول العلم للناقل بصدور الحكم عن الامام عليه السلام من جهة هذا الاتفاق إلا أنه إنما نقل سبب العلم ولم ينقل المعلوم وهو قول الامام عليه السلام حتى يدخل في نقل الحجة وحكاية السنة بخبر الواحد.
نعم، لو فرض أن السبب المنقول مما يستلزم عادة موافقة قول الامام، عليه السلام، أو وجود دليل ظني معتبر حتى بالنسبة إلينا، أمكن إثبات ذلك السبب المحسوس بخبر العادل والانتقال منه إلى لازمه.
لكن سيجئ بيان الاشكال في تحقق ذلك.
وفي حكم الاجماع المضاف إلى من عدا الامام، عليه السلام، الاجماع المطلق المذكور في مقابل الخلاف.
كما يقال: خرء الحيوان الغير المأكول غير الطير نجس إجماعا.
وإنما إختلفوا في خرء الطير.
أو يقال: إن محل الخلاف هو كذا.
وأما كذا فحكمه كذا إجماعا، فإن معناه في مثل هذا كونه قولا واحدا.
وأضعف مما ذكر نقل عدم الخلاف وأن ظاهر الاصحاب أو قضية المذهب وشبه ذلك.
وإن أطلق الاجماع أو أضافه على وجه يظهر منه إرادة المعنى المصطلح المتقدم ولو مسامحة، لتنزيل وجود المخالف منزلة العدم، لعدم قدحه في الحجية، فظاهطر الحكاية كونها حكاية للسنة، اعني حكم الامام، عليه السلام، لما عرفت من أن الاجماإع الاصطلاحي متضمن لقول الامام عليه السلام فيدخل في الخبر والحديث.
إلا أن مستند علم الحاكي بقول الامام، عليه السلام، أحد أمور: أحدها الحس، كما إذا سمع الحكم من الامام، عليه السلام، في جملة جماعة لا يعرف أعيانهم فيحصل له العلم بقول الامام عليه السلام.
وهذا في غاية القلة، بل نعلم أنه لم يتفق لاحد من هؤلاء الحاكين للاجماع، كالشيخين والسيدين وغيرهما.
ولذا صرح الشيخ في العدة، في مقام الرد على السيد حيث أنكر الاجماع من باب وجوب اللطف، بأنه لولا قاعدة اللطف لم يمكن التوصل إلى معرفة موافقة الامام للمجمعين.
الثاني قاعدة اللطف، على ما ذكره الشيخ في العدة وحكي القول به عن غيره من المتقدمين.
ولا يخفى أن الاستناد إليه غير صحيح، على ما ذكره في محله.
فإذا علم إستناده الحاكي إليه فلا وجه للاعتماد على حكايته.
والفروض أن إجماعات الشيخ كلها مستندة إلى هذه القاعدة، لما عرفت من كلامه المتقدم عن العدة وستعرف منها ومن غيرها من كتبه.
فدعوى مشاركته للسيد، قدس سره -، في إستكشاف قول الامام، عليه السلام، من تتبع أقوال الامة وإختصاصه بطريق آخر مبني على وجوب قاعدة اللطف - غير ثابتة، وإن إدعاها بعض، فإنه، قدس سره، قال في العدة، - في حكم ما إذا إختلفت الامامية على قولين يكون أحد القولين قول الامام، عليه السلام، على وجه لا يعرف بنفسه، والباقون كلهم على خلافه -: (إنه متى إتفق ذلك، فإن كان على القول الذي إنفرد به الامام، عليه السلام، دليل من كتاب أو سنة مقطوع بها لم يجب عليه الظهور ولا الدلالة على ذلك، لان الموجود من الدليل كاف في إزاحة التكليف، ومتى لم يكن عليه دليل وجب عليه الظهور أو إظهار من يبين الحق في تلك المسألة - إلى أن قال -: وذكر المرتضى علي بن الحسين الموسوي أخيرا: (أنه يجوز أن يكون الحق عند الامام، عليه السلام، والاقوال الاخر كلها باطلة.
ولا يجب عليه الظهور، لانا إذا كنا نحن السبب في إستتاره، فكل ما يفوتنا من الانتفاع به وبما معه من الاحكام يكون قد فاتنا من قبل أنفسنا، ولو أزلنا سبب الاستتار لظهر وانتفعنا به وأدى إلينا الحق الذي كان عنده).
قال: (وهذا عندي غير صحيح، لانه يؤدي إلى أن لا يصح الاحتجاج بإجماع الطائفة أصلا، لانا لا نعلم دخول الامام، عليه السلام، فيها إلا بالاعتبار الذي بيناه، ومتى جوزنا إنفراده بالقول وأنه لا يجب ظهوره منع ذلك من الاحتجاج بالاجماع)، إنتهى كلامه.
وذكر في موضع آخر من العدة: (إن هذه الطريقة - يعني طريقة السيد المتقدمة - غير مرضية عندي، لانها تؤدي إلى أن لا يستدل بإجماع الطائفة أصلا، لجواز أن يكون قول الامام، عليه السلام مخالفا لها، ومع ذلك لا يجب عليه إظهار ما عنده) إنتهى.
وأصرح من ذلك في إنحصار طريق الاجماع، عند الشيخ، فيما ذكره من قاعدة اللطف، ما حكي عن بعض أنه حكاه عن كتاب التهذيب [ التمهيد ] للشيخ: (أن سيدنا المرتضى، قدس سره، كان يذكر كثيرا أنه لا يمتنع أن يكون هنا أمور كثيرة غير واصلة إلينا علمها مودع عند الامام عليه السلام وإن كتمها الناقلون، ولا يلزم مع ذلك سقوط التكليف عن الخلق - إلى أن قال -: وقد إعترضنا على هذا في كتاب العدة في أصول الفقه وقلنا: هذا الجواب صحيح لولا ما نستدل في أكثر الاحكام على صحته بإجماع الفرقة.
فمتى جوزنا أن يكون قول الامام، عليه السلام، خلافا لقولهم ولا يجب ظهوره، جاز لقائل أن يقول: ما أنكرتم أن يكون قول الامام (ع) خارجا عن قول من تظاهر بالامامة ومع هذا لا يجب عليه الظهور، لانهم أتوا من قبل أنفسهم، فلا يمكننا الاحتجاج بإجماعهم أصلا)، إنتهى.
فإن صريح هذا الكلام أن القادح في طريقة السيد منحصر في إستلزامها رفع التمسك بالاجماع، ولا قادح فيها سوى ذلك، ولذا صرح في كتاب الغيبة بأنها قوية تقتضيها الاصول.
فلو كان لمعرفة الاجماع وجواز الاستدلال به طريق آخر غير قاعدة وجوب إظهار الحق عليه لم يبق ما يقدح في طريقة السيد، لاعتراف الشيخ بصحتها لولا كونها مانعة عن الاستدلال بالاجماع.
ثم إن الاستناد إلى هذا الوجه ظاهر من كل من إشترط في تحقق الاجماع عدم مخالفة أحد من علماء العصر، كفخر الدين والشهيد والمحقق الثاني.
قال في الايضاح في مسألة ما يدخل في المبيع: (إن من عادة المجتهد: إذا تغير إجتهاده إلى التردد أو الحكم بخلاف ما اختاره أولا، لم يبطل ذكر الحكم الاول، بل يذكر ما أدى إليه إجتهاده ثانيا في موضع آخر، لبيان عدم إنعقاد إجماع أهل عصر الاجتهاد الاول على خلافه، وعدم إنعقاد إجماع أهل العصل الثاني على كل واحد منهما.
وأنه لم يحصل في الاجتهاد الثاني مبطل للاول، بل معارض لدليله مساو له)، إنتهى.
وقد أكثر في الايضاح من عدم الاعتبار بالخلاف لانقراض عصر المخالف.
وظاهره الانطباق على هذه الطريقة، كما لا يخفى.
وقال في الذكرى: (ظاهر العلماء المنع عن العمل بقول الميت محتجين بأنه لا قول للميت، ولهذا ينعقد الاجماع على خلافه ميتا).
واستدل المحقق الثاني في حاشية الشرائع: (على أنه لا قول للميت، بالاجماع على أن خلاف الفقيه الواحد لسائر أهل عصره يمنع من إنعقاد الاجماع إعتدادا بقوله وإعتبارا بخلافه.
فإذا مات وانحصر أهل العصر في المخالفين له إنعقد وصار قوله غير منظور إليه ولا يعتد به)، إنتهى.
وحكي عن بعض أنه حكى عن المحقق الداماد أنه، قدس سره قال في بعض كلام له، في تفسير النعمة الباطنة: (إن من فوائد الامام - عجل الله فرجه - أن يكون مستندا لحجية إجماع أهل الحل والعقد من العلماء على حكم من الاحكام إجماعا بسيطا في أحكامهم الاجماعية وحجية إجماعهم المركب في أحكامهم الخلافية، فإنه - عجل الله فرجه - لا ينفرد بقول، بل من الرحمة الواجبة في الحكمة الالهية أن يكون في المجتهدين المختلفين في المسألة المختلف فيها من علماء العصر من يوافق رأيه رأي إمام عصره وصاحب أمره ويطابق قوله قوله وإن لم يكن ممن نعلمه بعينه ونعرفه بشخصه)، إنتهى.
وكأنه لاجل مراعاة هذا الطريقة إلتجا الشهيد في الذكرى إلى توجيه الاجماعات التي إدعاها جماعة في المسائل الخلافية مع وجود المخالف فيها بإرادة غير المعنى الاصطلاحي من الوجوه التي حكاها عنه في المعالم.
ولو جامع الاجماع وجود الخلاف ولو من معلوم النسب لم يكن داع إلى التوجيهات المذكورة مع بعدها أو أكثرها.
الثالث من طرق إنكشاف قول الامام عليه السلام لمدعى الاجماع الحدس.
وهذا على وجهين: أحدهما: أن يحصل له ذلك من طريق لو علمنا به ما خطأناه في إستكشافه.
وهذا على وجهين، أحدهما: أن يحصل له الحدس الضروري من مباد محسوسة بحيث يكون الخطأ فيه من قبيل الخطأ في الحس، فيكون بحيث لو حصل لنا تلك الاخبار لحصل لنا العلم كما حصل له.
ثانيهما: أن يحصل الحدس له من إخبار جماعة إتفق له العلم بعدم إجتماعهم على الخطأ، لكن ليس إخبارهم ملزوما
عادة للمطابقة لقول الامام، عليه السلام، بحيث لو حصل لنا علمنا بالمطابقة أيضا.
الثاني: أن يحصل ذلك من مقدمات نظرية وإجتهادات كثيرة الخطأ، بل علمنا بخطأ بعضها في موارد كثيرة من نقلة الاجماع، علمنا ذلك منهم بتصريحاتهم في موارد، واستظهرنا ذلك منهم في موارد أخر، وسيجئ جملة منها.
* * *
إذا عرفت أن مستند خبر المخبر بالاجماع المتضمن للاخبار من الامام، عليه السلام، لا يخلو من الامور الثلاثة المتقدمة - وهي السماع عن الامام مع عدم معرفته بعينه، وإستكشاد قوله من قاعدة اللطف، وحصول العلم من الحدس، وظهر لك أن الاول هنا غير متحقق عادة لاحد من علمائنتا المدعين للاجماع، وأن الثاني ليس طريقا للعلم - فلا يسمع دعوى من إستند إليه، فلم يبق مما يصلح أن يكون المستند في الاجماعات المتداولة على ألسنة ناقليها إلا الحدس.
وعرفت أن الحدس قد يستند إلى مباد محسوسة ملزومة عادة لمطابقة قول الامام، عليه السلام، نظير العلم الحاصل من الحواس الظاهرة، ونظير الحدس الحاصل لمن أخبر بالعدالة والشجاعة لمشاهدته آثارهما المحسوسة الموجبة للانتقال إليهما بحكم العادة أو إلى مباد محسوسة موجبة لعلم المدعي بمطابقة قول الامام، عليه السلام، من دون ملازمه عادية، وقد يستند إلى إجتهادات وأنظار.
وحيث لا دليل على قبول خبر العادل المستند إلى القسم الاخير من الحدس، بل ولا المستند إلى الوجه الثاني، ولم يكن هناك ما يعلم به كون الاخبار مستندا إلى القسم الاول من الحدس، وجب التوقف في العمل بنقل الاجماع، كسائر الاخبار المعلوم إستنادها إلى الحدس المردد بين الوجوه المذكورة.
فإن قلت: ظاهر لفظ الاجماع إتفاق الكل، فإذا أخبر الشخص بالاجماع فقد أخبر بإتفاق الكل، ومن المعلوم أن حصول العلم بالحكم من إتفاق الكل كالضروري، فحدس المخبر مستند إلى مباد محسوسة ملزومة لمطابقة قول الامام، عليه السلام، عادة.
فإما أن يجعل الحجة نفس ما استفاده من الاتفاق، نظير الاخبار بالعدالة، وإما أن يجعل الحجة إخباره بنفس الاتفاق المستلزم عادة لقول الامام، عليه السلام، ويكون نفس المخبر به حينئذ محسوسا، نظير إخبار الشخص بأمور تستلزم العدالة أو الشجاعة عادة.
وقد أشار إلى الوجهين بعض السادة الاجلة في شرحه على الوافية، فإنه قدس سره، لما إعترض على نفسه: ب (أن المعتبر من الاخبار ما إستند إلى إحدى
الحواس، والمخبر بالاجماع إنما رجع إلى بذل الجهد، ومجرد الشك في دخول مثل ذلك في الخبر يقتضي منعه).
أجاب عن ذلك: بأن المخبر هنا أيضا يرجع إلى السمع فيما يخبر عن العلماء وإن جاء العلم بمقالة المعصوم من مراعاة أمر آخر، كوجوب اللطف وغيره.
ثم أورد: بأن المدار في حجية الاجماع على مقالة المعصوم عليه السلام.
فالاخبار إنما هو بها ولا يرجع إلى سمع.
فأجاب عن ذلك: أولا، بأن مدار الحجية وإن كان ذلك، لكن إستلزام إتفاق كلمة العلماء لمقالة المعصوم عليه السلام معلوم لكل أحد، لا يحتاج فيه إلى النقل.
و إنما الغرض من النقل ثبوت الاتفاق.
فبعد إعتبار خبر الناقل لوثاقته ورجوعه في حكاية الاتفاق إلى الحس والسماع كان الاتفاق معلوما، ومتى ثبت ذلك كشف عن مقالة المعصوم للملازمة المعلومة لكل أحد.
وثانيا، أن الرجوع في حكاية الاجماع إلى نقل مقالة المعصوم لرجوع الناقل في ذلك إلى الحس، بإعتبار أن الاتفاق من آثاره.
ولا كلام في إعتبار مثل ذلك، كما في الاخبار بالايمان والفسق والشجاعة والكرم وغيرها من الملكات.
وإنما لا يرجع إلى الاخبار في العقليات المحضة، فإنه لا يعول عليها، وإن جاء بها ألف من الثقات حتى يدرك مثل ما أدركوا.
ثم أورد على ذلك: بأنه يلزم من ذلك الرجوع إلى المجتهد، لانه وإن لم يرجع إلى الحس في نفس الاحكام إلا أنه رجع في لوازمها وآثارها إليه، وهي أدلتها السمعية، فيكون رواية، فلم لا يقبل إذا جاء به الثقة.
وأجاب: بأنه إنما يكفي الرجوع إلى الحس في الآثار إذا كانت الآثار مستلزمة له عادة، وبالجملة إذا أفادت اليقين، كما في آثار الملكات وآثار مقالة الرئيس، وهي مقالة رعيته.
وهذا بخلاف ما يستنهضه المجتهد من الدليل على الحكم.
ثم قال: على أن التحقيق في الجواب عن السؤال الاول هو الوجه الاول، و عليه فلا أثر لهذا السوال)، إنتهى.
قلت إن الظاهر من الاجماع إتفاق أهل عصر واحد، لا جميع الاعصار، كما يظهر من تعاريفهم وسائر كلماتهم.
ومن المعلوم أن إجماع أهل عصر واحد مع قطع النظرعن موافقة أهالي الاعصار المتقدمة ومخالفتهم، لا يوجب عن طريق الحدس العلم الضروري بصدور الحكم عن الامام، عليه السلام، ولذا قد يتخلف، لاحتمال مخالفة من تقدم عليهم أن أكثرهم.
نعم يفيد العلم من باب وجوب اللطف الذي لا نقول بجريانه في المقام، كما قرر في محله.
مع أن علماء العصر إذا كثروا، كما في الاعصار السابقة، يتعذر أو يتعسر الاطلاع عليهم حسا بحيث يقطع مع سواهم في العصر، إلا إذا كان العلماء في عصر قليلين يمكن الاحاطة بآرائهم في المسألة فيدعى الاجماع، إلا أن مثل هذا الامر المحسوس لا يستلزم عادة لموافقة المعصوم عليه السلام.
فالمحسوس المستلزم عادة لقول الامام عليه السلام مستحيل التحقق للناقل، والممكن التحقق له غير مسلتزم عادة.
وكيف كان، فإذا إدعى الناقل الاجماع، خصوصا إذا كان ظاهره إتفاق جميع علماء الاعصار أو أكثرهم إلا من شذ - كما هو الغالب في إجماعات مثل الفاضلين والشهيدين - إنحصر محمله في وجوه: أحدهما: أن يراد به إتفاق المعروفين بالفتوى دون كل قابل للفتوى من أهل عصره أو مطلقا.
الثاني: أن يراد إجماع الكل.
ويستفيد ذلك من إتفاق المعروفين من أهل عصره.
وهذه الاستفادة ليست ضرورية وإن كانت قد تحصل، لان إتفاق أهل عصره، فضلا عن المعروفين منهم، لا يستلزم عادة إتفاق غيرهم ومن قبلهم، خصوصا بعد ملاحظة التخلف في كثير من الموارد، لا يسع هذا الرسالة لذكر معشارها.
ولو فرض حصوله للمخبر كان من باب الحدس الحاصل عما لا يوجب العلم عادة.
نعم هي إمارة ظنية على ذلك، لان الغالب في الاتفاقيات عند أهل عصر كونه من الاتفاقيات عند من تقدمهم.
وقد يحصل العلم بضميمة أمارات أخر، لكن الكلام في كونه الاتفاق مستندا إلى الحس أو إلى حدس لازم عادة للحس.
وألحق بذلك ما إذا علم إتفاق الكل من إتفاق جماعة، لحسن ظنه بهم، كما ذكره في أوائل المعتبر حيث قال: (ومن المقلدة من لو طالبته بدليل المسألة إدعى الاجماع، لوجوده في كتب الثلاثة قدست أسرارهم.
وهو جهل إن لم يكن تجاهلا).
فإن في توصيف المدعي بكونه مقلدا، مع أنا نعلم أنه لا يدعي الاجماع إلا عن علم، إشارة إلى إستناده في دعواه إلى حسن الظن بهم وأن جزمه في غير محله، فافهم.
الثالث: أن يستفيد إتفاق الكل على الفتوى من إتفاقهم على العمل بالاصل عند عدم الدليل، أو بعموم دليل عند عدم وجدان المخصص، أو بخبر معتبر عند عدم وجدان المعارض، أو إتفاقهم على مسألة أصولية نقلية أو عقليه يستلزم القول بها الحكم في المسألة المفروضة، وغير ذلك من الامور المتفق عليها التي يلزم بإعتقاد المدعي من القول بها، مع فرض عدم المعارض، القول بالحكم المعين في المسالة.
ومن المعلوم: أن نسبة هذا الحكم إلى العلماء في مثل ذلك لم تنشأ إلا من مقدمتين أثبتهما المدعي بإجتهاده: إحداهما كون ذلك الامر المتفق عليه مقتضيا ودليلا للحكم لولا المانع.
و الثانية إنتفاء المانع والمعارض.
ومن المعلوم أن الاستناد إلى الخبر المستند إلى ذلك غير جائز عند أحد من العاملين بخبر الواحد.
* * *
ثم إن الظاهر أن الاجماعات المتعارضة من شخص واحد أو من معاصرين أو متقاربي العصرين ورجوع المدعي عن الفتوى التي إدعى الاجماع فيها ودعوى الاجماع في مسائل غير معنونة في كلام من تقدم على المدعي وفي مسائل قد إشتهر خلافها بعد المدعي، بل في زمانه، بل في ماقبله، كل ذلك مبني على الاستناد في نسبة القول إلى العلماء على هذا الوجه.
ولا بأس بذكر بعض موارد صرح المدعي بنفسه أو غيره في مقام توجيه كلامه فيها بذلك.
فمن ذلك: ما وجه به المحقق دعوى المرتضى والمفيد: أن من مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات.
قال: (وأما قول السائل: كيف أضاف المفيد والسيد ذلك إلى مذهبنا ولا نص فيه، فالجواب: أما علم الهدى، فإنه ذكر في الخلاف: أنه إنما أضاف ذلك إلى مذهبنا، لان من أصلنا العمل بالاصل ما لم يثبت الناقل، وليس في الشرع ما يمنع الازالة بغير الماء من المائعات - ثم قال -: وأما المفيد، فإنه إدعى في مسائل الخلاف: أن ذلك مروي عن الائمة)، إنتهى.
فظهر من ذلك أن نسبة السيد، قدس سره، الحكم المذكور إلى مذهبنا من جهة الاصل.
ومن ذلك ما عن الشيخ في الخلاف، حيث أنه ذكر، فيما إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل به القتل، بأنه يسقط القود وتكون الدية من بيت المال، قال: (دليلنا إجماع الفرقة، فإنهم رووا أن ما أخطأت القضاة، ففي بيت مال المسلمين)، إنتهى.
فعلل إنعقاد الاجماع بوجود الرواية عند الاصحاب.
وقال بعد ذلك، فيما إذا تعددت الشهود فيمن أعتقه المريض وعين كل غير ما عينه الاخر، ولم يف الثلث بالجميع: (إنه يخرج السابق بالقرعة، - قال -: دليلنا إجماع الفرقة وإخبارهم، فإنهم أجمعوا على أن كل أمر مجهول فيه القرعة)، إنتهى.
ومن هذا القبيل ما عن المفيد في فصوله، حيث أن سئل عن الدليل على أن المطلقة ثلاثا في مجلس واحد يقع منها واحدة.
فقال: (الدلالة على ذلك من كتاب الله عزوجل وسنة نبيه، صلى الله عليه وآله، وإجماع المسلمين)، ثم إستدل من الكتاب بظاهر قوله تعالى: (الطلاق مرتان).
ثم بين وجه الدلالة، ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله: (كل ما لم يكن على أمرنا هذا فهو رد)، وقال: (ما وافق الكتاب فخذوه، وما لم يوافقه فاطرحوه).
و قد بينا أن المرة لا تكون المرتين أبدا وأن الواحدة لا تكون ثلاثا، فأوجب السنة إبطال طلاق الثلاث.
وأما إجماع الامة، فهو مطبقون على أن ما خالف الكتاب و السنة فهو باطل.
وقد تقدم وصف خلاف الطلاق بالكتاب والسنة، فحصل الاجماع على إبطاله)، إنتهى.
وحكي عن الحلي في السرائر الاستدلال بمثل هذا.
ومن ذلك الاجماع الذي إدعاه الحلي على المضايقة في قضاء الفوائت في رسالته المسماة بخلاصة الاستدلال، حيث قال: (أطبقت عليه الامامية خلفا عن سلف وعصرا بعد عصر وأجمعت على العمل به، ولا يعتد بخلاف نفر يسير من الخراسانيين، فإن إبني بابويه، والاشعريين،
كسعد بن عبدالله صاحب كتاب الرحمة، وسعد بن سعد، ومحمد بن علي بن محبوب صاحب كتاب نوادر الحكمة، والقميين أجمع، كعلي بن إبراهيم بن هاشم، ومحمد بن الحسن بن الوليد، عاملون بأخبار المضايقة، لانهم ذكروا أنه لا يحل رد الخبر الموثوق برواته، وحفظتهم الصدوق ذكر ذلك في كتاب من لا يحضره الفقيه، وخريت هذه الصناعة ورئيس الاعاجم الشيخ أبوجعفر الطوسي مودع أخبار المضايقة في كتبه مفت بها.
والمخالف إذا علم بإسمه ونسبه لم يضر خلافه) إنتهى.
ولا يخفى أن إخباره بإجماع العلماء على الفتوى بالمضايفه مبني على الحدس والاجتهاد من وجوه: أحدها: دلالة ذكر الخبر على عمل الذاكر به.
وهذا وإن كان غالبيا إلا أنه لا يوجب القطع، لمشاهدة التخلف كثيرا.
الثاني: تمامية دلالة تلك الاخبار عند أولئك على الوجوب، إذ لعلهم فهموا منها بالقرائن الخارجية تأكد الاستحباب.
الثالث: كون رواة تلك الروايات موثوقا بهم عند أولئك، لان وثوق الحلي بالرواة لا يدل على وثوق أولئك، مع أن الحلي لا يرى جواز العمل بأخبار الآحاد وإن كانوا ثقات، والمفتي إذا إستند فتواه إلى خبر واحد لا يوجب إجتماع أمثاله القطع بالواقع، خصوصا لمن يخطئ العمل بأخبار الآحاد.
وبالجملة فكيف يمكن أن يقال: إن مثل هذا الاجماع إخبار عن قول الامام، فيدخل في الخبر الواحد، مع أنه في الحقيقة إعتماد على إجتهادات الحلي مع وضوح فساد بعضها، فإن كثيرا ممن ذكر أخبار المضايقة قد ذكر أخبار المواسعة أيضا، وأن المفتي إذا علم إستناده إلى مدرك لا يصلح للركون إليه من جهة الدلالة أو المعارضة لا يؤثر فتواه في الكشف عن قول الامام.
وأوضح حالا في عدم جواز الاعتماد ما ادعاه الحلي من الاجماع على وجوب فطرة الزوجة ولو كانت ناشزه على الزوج.
ورده المحقق بأن أحدا من علماء الاسلام لم يذهب إلى ذلك.
فإن الظاهر أن الحلي إنما اعتمد في إستكشاف أقوال العلماء على تدوينهم للروايات الدالة بإطلاقها على وجوب فطرة الزوجة على الزوج، متخيلا أن الحكم معلق على الزوجة من حيث هي زوجة، ولم يتفطن
لكون الحكم من حيث العيلولة أو وجوب الانفاق.
فكيف يجوز الاعتماد في مثله على الاخبار بالاتفاق الكاشف عن قول الامام عليه السلم ويقال إنها سنة محكية.
وما أبعد ما بين ما إستند إليه الحلي في هذا المقام وبين ما ذكره المحقق في بعض كلماته المحكية، حيث قال: (إن الاتفاق على لفظ مطلق شامل لبعض أفراده الذي وقع فيه الكلام لا يقتضي الاجماع على ذلك الفرد، لان المذهب لا يصار إليه من إطلاق اللفظ ما لم يكن معلوما من القصد، لان الاجماع مأخوذ من قولهم: أجمع على كذا، إذا عزم عليه.
فلا يدخل في الاجماع على الحكم إلا من علم منه القصد إليه.
كما أنا لا نعلم مذهب عشرة من الفقهاء الذين لم ينقل مذهبهم لدلالة عموم القرآن وإن كانوا قائلين به)، إنتهى كلامه.
وهو في غاية المتانة.
لكنك عرفت ما وقع من جماعة من المسامحة في إطلاق لفظ الاجماع.
وقد حكي في المعالم عن الشهيد: (إنه أول كثيرا من الاجماعات، لاجل مشاهدة المخالف في مواردها، بإرادة الشهرة، أو بعدم الظفر بالمخالف حين دعوى الاجماع، أو بتأويل الخلاف على وجه لا ينافي الاجماع، أو بإرادة الاجماع على الرواية وتدوينها في كتب الحديث) إنتهى.
وعن المحدث المجلسي، قدس سره، في كتاب الصلاة من البحار.
، بعد ذكر معنى الاجماع ووجه حجيته عند الاصحاب: (إنهم لما رجعوا إلى الفقه كأنهم نسوا ما ذكروه في الاصول.
ثم أخذ في الطعن على إجماعاتهم إلى أن قال: - فيغلب على الظن أن مصطلحهم في الفروع غير ما جروا عليه فلا الاصول) إنتهى.
والتحقيق أنه لا حاجة إلى إرتكاب التأويل في لفظ الاجماع لما ذكره الشهيد، ولا إلى ما ذكره المحدث المذكور، قدس سرهما، من تغاير مصطلحهم في الفروع والاصول، بل الحق أن دعواهم للاجماع في الفروع مبني على إستكشاف الآراء ورأي الامام، عليه السلام، إما من حسن الظن
بجماعة من السلف أو من أمور تسلتزم بإجتهادهم إفتاء العلماء بذلك وصدور الحكم عن الامام عليه السلام أيضا.
وليس في هذا مخالفة لظاهر لفظ الاجماع حتى يحتاج إلى القرينة، ولاتدليس، لان دعوى الاجماع ليس لاجل إعتماد الغير عليه وچعله دليلا يستريح إليه في المسألة.
نعم قد يوجب التدليس من جهة نسبة الفتوى إلى العلماء، الظاهرة في وجدانها في كلماتهم، لكنه يندفع بأدنى تتبع في (الفقه)، ليظهر أن مبنى ذلك على إستنباط المذهب، لا على وجدانه مأثورا.
والحاصل: أن المتتبع في الاجماعات المنقولة يحصل له القطع من تراكم أمارات كثيرة بإستناد دعوى الناقلين للاجماع خصوصا إذا أرادوا به إتفاق علماء جميع الاعصار، كما هو الغالب في إجماعات المتأخرين - إلى الحدس الحاصل من حسن الظن بجماعة ممن تقدم على الناقل، أو من الانتقال من الملزوم إلى لازمه مع ثبوت الملازمة بإجتهاد الناقل وإعتقاده.
وعلى هذا ينزل الاجماعات المتخالفة من العلماء مع إتحاد العصر أو تقارب العصرين وعدم المبالاة كثيرا بإجماع الغير والخروج عنه للدليل.
وكذا دعوى الاجماع مع وجود المخالف.
فإن ما ذكرنا في مبنى الاجماع من أصح المحامل لهذه الامور المنافية لبناء دعوى الاجماع على تتبع الفتاوى في خصوص المسألة.
وذكر المحقق السبزواري في الذخيرة، بعد بيان تعسر العلم بالاجماع: (أن مرادهم بالاجماعات المنقولة، في كثير من المسائل بل في أكثرها، لا يكون محمولا على معناه الظاهر، بل إما يرجع إلى إجتهاد من الناقل مؤد بحسب القرائن و الامارات التي إعتبرها إلى أن المعصوم، عليه السلام، موافق في هذا الحكم، أو مرادهم الشهرة أو إتفاق أصحاب الكتب المشهورة، أو غير ذلك من المعاني المحتملة).
ثم قال بعد كلام له: (والذي ظهر لي من تتبع كلام المتأخرين أنهم كانوا ينظرون إلى كتب الفتاوي الموجودة عندهم في حال التأليف، فإذا رأوا إتفاقهم على حكم قالو إنه إجماعي.
ثم إذا إطلعوا على تصنيف آخر خالف مؤلفه الحكم المذكور، رجعوا عن الدعوى المذكورة.
ويرشد إلى هذا كثير من القرائن التي لا يناسب هذا المقام تفصيلها)، إنتهى.
وحاصل الكلام، من أول ما ذكرنا إلى هنا، أن الناقل للاجماع إن أحتمل في حقه تتبع فتاوى من إدعى إتفاقهم حتى الامام الذي هو داخل في المجمعين، فلا إشكال في حجيته وفي إلحاقه بالخبر الواحد، إذ لا يشترط في حجيته معرفة الامام تفصيلا حين السماع منه.
لكن هذا الفرض مما يعلم بعدم وقوعه وأن المدعى للاجماع لا يدعيه على هذا الوجه.
وبعد هذا فإن احتمل في حقه تتبع فتاوي جميع المجمعين، والمفروض أن الظاهر من كلامه هو إتفاق الكل المستلزم عادة لموافقه قول الامام عليه السلام، فالظاهر حجية خبره للمنقول إليه، سواء جعلنا المناط في حجيته تعلق خبره بنفس الكاشف الذي هو من الامور المحسوسة المستلزمة ضرورة لامر حدسي وهو قول الامام، أو جعلنا المناط تعلق خبره بالمنكشف وهو قول الامام، لما عرفت من أن الخبر الحدسي المستند إلى إحساس ما هو ملزوم للمخبر به عادة، كالخبر الحسي في وجوب القبول.
وقد تقدم الوجهان في كلام السيد الكاظمي في شرح الوافية.
لكنك قد عرفت سابقا القطع بإنتفاء هذا الاحتمال، خصوصا إذا أراد الناقل إتفاق علماء جميع الاعصار.
نعم لو فرضنا قلة العلماء في عصر بحيث يحاط بهم، أمكن دعوى إتفاقهم عن حس، لكن هذا غير مستلزم عادة لموافقته قول الامام، عليه السلام.
نعم يكشف عن موافقته، بناء على طريقة الشيخ المتقدمه التي لم تثبت عندنا وعند الاكثر.
ثم إذا علم عدم إستناد دعوى إستناد دعوى إتفاق العلماء المتشتتين في الاقطار الذي يكشف عادة عن موافقة الامام عليه السلام إلا إلى الحدس الناشي عن أحد الامور المتقدمة التي مرجعها إلى حسن الظن أو الملازمات الاجتهادية، فلا عبرة بنقله، لان الاخبار بقول الامام عليه السلام حدسي غير مستند إلى حس ملزوم له عادة، ليكون نظير الاخبار بالعدالة المستندة إلى الآثار الحسية، والاخبار بالاتفاق أيضا حدسي.
نعم يبقى هنا شئ، وهو أن هذا المقدار من النسبة المحتمل إستناد الناقل فيها إلى الحس يكون خبره حجة فيها، لان ظاهر الحكاية محمول على الوجدان إلا إذا قام هناك صارف، والمعلوم من الصارف هو عدم إستناد الناقل إلى الوجدان والحس في نسبة الفتوى إلى جميع من إدعى إجماعهم.
وأما إستناد نسبة الفتوى إلى جميع أرباب الكتب المصنفة في الفتاوى إلى الوجدان في كتبهم بعد التتبع، فأمر محتمل لا يمنعه عادة ولا عقل.
وما تقدم من المحقق السبزواري، من إبتناء دعوى الاجماع على ملاحظة الكتب الموجودة عنده
حال التأليف، فليس عليه شاهد، بل الشاهد على خلافه.
وعلى تقدير فهو ظن لا يقدح في العمل بظاهر النسبة، فإن نسبة الامر الحسي إلى شخص ظاهر في إحساس الغير إياه من ذلك الشخص.
وحينئذ فنقل الاجماع غالبا إلا ما شذ حجة بالنسبة إلى صدور الفتوى عن جميع المعروفين من أهل الفتاوى.
ولا يقدح في ذلك أنا نجد الخلاف في كثير من موارد دعوى الاجماع، إذ من المحتمل إرادة الناقل ما عدا المخالف، فتتبع كتب من عداه ونسب الفتوى إليهم، بل لعله إطلع على رجوع من نجده مخالفا.
فلا حاجة إلى حمل كلامه على من عدا المخالف.
وهذا المضمون المخبر به عن حس، وإن لم يكن مستلزما بنفسه عادة لموافقة قول الامام، عليه السلام، إلا أنه قد يستلزمه بإنضمام أمارات أخر يحصلها المتتبع أو بإنضمام أقوال المتأخرين من دعوى الاجماع.
مثلا، إذا ادعى الشيخ، قدس سره، إلاجماع على إعتبار طهارة مسجد الجبهة، فلا أقل من إحتمال أن يكون دعواه مستندة إلى وجدان الحكم في الكتب المعدة للفتوى وإن كان بإيراد الروايات التي يفتي المؤلف بمضمونها.
فيكون خبره المتضمن لافتاء جميع أهل الفتوى بهذا الحكم حجة في المسألة.
فيكون كما لو وجدنا الفتاوى في كتبهم، بل سمعناها منهم.
وفتواهم وإن لم تكن بنفسها مستلزمة، عادة، لموافقة الامام، عليه السلام، إلا أنا إذا ضممنا إليها فتوى من تأخر عن الشيخ من أهل الفتوى وضم إلى ذلك أمارات أخر، فربما حصل من المجموع القطع بالحكم، لاستحالة تخلف هذه جميعها عن قول الامام، عليه السلام.
وبعض هذا المجموع - وهو إتفاق أهل الفتاوى المأثورة عنهم - وإن لم يثبت لنا بالوجدان، إلا أن المخبر قد أخبر به عن حس، فيكون حجة كالمحسوس لنا.
وكما أن مجموع ما يستلزم عادة لصدور الحكم عن الامام، عليه السلام، إذا أخبر به العادل عن حس قبل منه وعمل بمقتضاه، فكذا إذا أخبر العادل ببعضه عن حس.
وتوضيحه، بالمثال الخارجي، أن نقول: إن خبر مائة عادل أو ألف مخبر بشئ مع شدة إحتياطهم في مقام الاخبار يستلزم عادة ثبوت المخبر به في الخارج، فإذا أخبرنا عادل بأنه قد أخبر الف عادل بموت زيد وحضور دفنه، فيكون خبره بإخبار الجماعة بموت زيد حجة، فيثبت به لازمه العادي وهو موت زيد.
وكذلك إذا أخبر العادل بإخبار بعض هؤلاء وحصلنا إخبار الباقي بالسماع منهم.
نعم لو كانت الفتاوى المنقولة إجمالا بلفظ الاجماع على تقدير ثبوتها لنا بالوجدان مما لا يكون بنفسها أو بضميمة أمارات أخر مستلزمة عادة للقطع بقول الامام عليه السلام وإن كانت قد تفيده، لم يكن معنى لحجية خبر الواحد في نقلها تعبدا، لان معنى التعبد بخبر الواحد في شئ ترتيب لوازمه الثابتة له ولو بضميمة أمور أخر.
فلو أخبر العادل باخبار عشرين بموت زيد وفرضنا أن إخبارهم قد يوجب العلم وقد لا يوجب، لم يكن خبره حجة بالنسبة إلى موت زيد، إذ لا يلزم من إخبار عشرين بموت زيد موته.
وبالجملة، فمعنى حجية خبر العادل وجوب ترتيب ما يدل عليه المخبر به مطابقة، أو تضمنا، أو إلتزاما عقليا أو عاديا أو شرعيا، دون ما يقارنه أحيانا.
ثم إن ما ذكرنا لا يختص بنقل الاجماع، بل يجري في نقل الاتفاق وشبهه، ويجري في نقل الشهرة ونقل الفتاوى عن أربابها تفصيلا.
ثم إنه لو لم يحصل من مجموع ما ثبت بنقل العادل وما حصله المنقول إليه بالوجدان من الامارات والاقوال القطع بصدور الحكم الواقعي عن الامام، عليه السلام، لكن حصل منه القطع بوجود دليل ظني معتبر بحيث لو نقل إلينا لاعتقدناه تاما من جهة الدلالة وفقد المعارض، كان هذا المقدار أيضا كافيا في إثبات المسألة الفقهية، بل قد يكون نفس الفتاوى التي نقلها الناقل للاجماع إجمالا مستلزما لوجود دليل معتبر، فيستقل الاجماع المنقول بالحجية بعد إثبات حجية خبر العادل في المحسوسات، إلا إذا منعنا - كما تقدم سابقا - عن إستلزام إتفاق أرباب الفتاوى عادة لوجود دليل لو نقل إلينا لوجدناه تاما، وإن كان قد يحصل العلم بذلك من ذلك، إلا أن ذلك شئ قد يتفق ولا يوجب ثبوت الملازمة العادية التي هي المناط في الانتقال من المخبر به إليه.
ألا ترى أن إخبار عشرة بشئ قد يوجب العلم به، لكن لا ملازمة عادية بينهما، بخلاف إخبار ألف عادل محتاط في الاخبار.
وبالجملة، يوجد في الخبر مرتبة تستلزم عادة تحقق المخبر به، لكن ما يوجب العلم أحيانا قد لا يوجبه، وفي الحقيقة ليس هو بنفسه الموجب في مقام حصول العلم وإلا لم يتخلف.
* * *
ثم إنه قد نبه على ما ذكرنا من فائدة نقل الاجماع بعض المحققين في كلام طويل له.
وما ذكرنا وإن كان محصل كلامه على ما نظرنا فيه، لكن الاولى نقل عبارته بعينها.
فلعل الناظر يحصل منه غير ما حصلنا، فإنا قد مررنا على العبارة مرورا.
ولا يبعد أن يكون قد إختفى علينا بعض ما له
دخل في مطلبه.
قال قدس سره في كشف القناع وفي رسالته التي صنفها في المواسعة والمضايقة ما هذا لفظه: (وليعلم أن المحقق في ذلك هو أن الاجماع، الذي نقل بلفظه المستعمل في معناه المصطلح أو بسائر الالفاظ على كثرتها، إذا لم يكن مبتنيا على دخول المعصوم بعينه أو ما في حكمه في المجمعين، فهو إنما يكون حجة على غير الناقل بإعتبار نقله السبب الكاشف عن قول المعصوم أو عن الدليل القاطع أو مطلق الدليل المعتد به وحصول الانكشاف للمنقول إليه والتمسك به بعد البناء على قبوله، لا بإعتبار ما إنكشف منه لناقله بحسب إدعائه.
فهنا مقامان:
الاول حجيته بالاعتبار الاول، وهي مبتنية من جهتي الثبوت والاثبات على مقدمات: الاولى: دلالة اللفظ على السبب.
وهذه لابد من إعتبارها، وهي متحققة ظاهرا في الالفاظ المتداولة بينهم ما لم يصرف عنها صارف.
وقد يشتبه الحال إذا كان النقل بلفظ الاجماع في مقام الاستدلال، لكن من المعلوم أن مبناه ومبنى غيره ليس على الكشف الذي يدعيه جهال الصوفية، ولا على الوجه الاخير الذي إن وجد في الاحكام ففي غاية الندرة، مع أنه على تقدير بناء الناقل عليه وثبوته واقعا كاف في الحجية.
فإذا إنتفى الامران تعين سائر الاسباب المقررة، وأظهرها غالبا عند الاطلاق حصول الاطلاع بطريق القطع أو الظن المعتد به على إتفاق الكل في نفس الحكم.
ولذا صرح جماعة منهم بإتحاد معنى الاجماع عند الفريقين وجعلوه مقابلا للشهرة.
وربما بالغوا في أمرها بأنها كادت تكون إجماعا ونحو ذلك.
وربما قالوا: إن كان هذا مذهب فلان فالمسألة إجماعية، وإذا لوحظت القرائن الخارجية من جهة العبارة والمسألة والنقلة واختلف الحال في ذلك.
فيؤخذ بما هو المتيقن أو الظاهر.
وكيف كان، فحيث دل اللفظ ولو بمعونة القرائن على تحقق الاتفاق المعتبر كان معتبرا، وإلا فلا.
الثانية: حجية نقل السبب المذكور وجواز التعويل عليه.
وذلك لانه ليس إلا
كنقل فتاوى العلماء وأقوالهم وعباراتهم الدالة عليها لمقلديهم وغيرهم، ورواية ما عدا قول المعصوم ونحوه من سائر ما تضمنه الاخبار، كالاسؤلة التي تعرف منها أجوبته، والاقول والافعال التي يعرف منها تقريره، ونحوها مما تعلق بها، وما نقل عن سائر الرواة المذكورين في الاسانيد وغيرها، وكنقل الشهرة وإتفاق سائر أولي الآراء والمذاهب وذوي الفتوى أو جماعة منهم وغير ذلك.
وقد جرت طريقة السلف والخلف من جيمع الفرق على قبول أخبار الآحاد في كل ذلك، مما كان النقل فيه على وجه الاجمال أو التفصيل وما تعلق بالشرعيات أو غيرها، حتى أنهم كثيرا ما ينقلون شيئا مما ذكر معتمدين على نقل غيرهم من دون تصريح بالنقل عنه والاستناد إليه لحصول الوثوق به وإن لم يصل إلى مرتبة العلم.
فيلزم قبول خبر الواحد فيما نحن فيه أيضا، لاشتراك الجميع في كونها نقل قول غير معلوم من غير معصوم وحصول الوثوق بالناقل، كما هو المفروض.
وليس شئ من ذلك الوصول حتى يتوهم عدم الاكتفاء فيه بخبر الواحد مع أن هذا الوهم فاسد من أصله، كما قرر في محله - ولا من الامور المتجددة التي لم يعهد الاعتماد فيها على خبر الواحد في زمان النبي صلى الله عليه وآله والائمه عليهم السلام والصحابة، ولا مما ينذر اختصاص معرفته ببعض دون بعض، مع أن هذا لا يمنع من التعويل على نقل العارف به، لما ذكر.
ويدل عليه مع ذلك ما دل على حجية خبر الثقة العدل بقول مطلق وما اقتضى كفاية الظن فيما لا غنى عن معرفته ولا طريق إليه غيره غالبا.
إذ من المعلوم شدة الحاجة إلى معرفة أقوال علماء الفريقين وأراء سائر أرباب العلوم لمقاصد شتى لا محيص عنها، كمعرفة المجمع عليه والمشهور والشاذ من الاخبار والاقوال والموافق للعامة أو أكثرهم والمخالف لهم والثقة والاوثق والاورع والافقه، وكمعرفة اللغات وشواهدها المنثورة والمنظومة وقواعد العربية التي عليها يبتنى إستنباط المطالب الشرعية وفهم معاني الاقارير والوصايا وسائر العقود والايقاعات المشتبة، وغير ذلك مما لا يخفى على المتأمل.
ولا طريق إلى ما اشتبه من جميع ذلك غالبا سوى النقل الغير الموجب للعلم والرجوع إلى الكتب المصححة ظاهرا وسائر الامارات الظنية.
فيلزم جواز العمل بها
والتعويل عليها فيما ذكر.
فيكون خبر الواحد الثقة حجة معتمدا عليها فيما نحن فيه، ولا سيما إذا كان الناقل من الافاضل الاعلام والاجلاء الكرام، كما هو الغالب، بل هو أولى بالقبول والاعتماد من أخبار الآحاد في نفس الاحكام، ولذا بني على المسامحة فيه من وجوه شتى بما لم يتسامح فيها، كما لا يخفى.
الثالثة: حصول إستكشاف الحجة المعتبرة من ذلك السبب.
ووجهه أن السبب المنقول بعد حجيته كالمحصل فيما يستكشف منه والاعتماد عليه وقبوله وإن كان من الادلة الظنية بإعتبار ظنية أصله.
ولذا كانت النتيجة في الشكل الاول تابعة في الضرورية والنظرية والعلمية والظنية وغيرها لاخس مقدمتيه مع بداهة إنتاجه.
فينبغي حينئذ أن يراعى حال الناقل حين نقله من جهة ضبطه وتورعه في النقل وبضاعته في العلم ومبلغ نظره ووقوفه على الكتب والاقول وإستقصائه لما تشتت منها ووصوله إلى وقائعها، فإن أحوال العلماء مختلف فيها إختلافا فاحشا.
وكذلك حال الكتب المنقول فيها الاجماع، فرب كتاب لغير متتبع موضوع على مزيد التتبع والتدقيق.
ورب كتاب لمتتبع موضوع على المسامحة وقلة التحقيق.
ومثله الحال في آحاد المسائل، فإنها تختلف أيضا في ذلك.
وكذا حال لفظه بحسب وضوح دلالته على السبب وخفائها، وحال ما يدل عليه من جهة متعلقه وزمان نقله لاختلاف الحكم بذلك، كما هو ظاهر.
ويراعى أيضا وقوع دعوى الاجماع في مقام ذكر الاقوال أو الاحتجاج، فإن بينهما تفاوتا من بعض الجهات.
وربما كان الاولى بالاعتماد بناء على إعتبار السبب، كما لا يخفى فإذا وقع إلتباس فيما يقتضيه ويتناوله كلام الناقل بعد ملاحظة ما ذكر أخذ بما هو المتيقن أو الظاهر.
ثم ليلحظ مع ذلك ما يمكن معرفته من الاقوال على وجه العلم واليقين، إذ لا وجه لاعتبار المظنون المنقول على سبيل الاجمال دون المعلوم على التفصيل.
مع أنه لو كان المنقول معلوما لما اكتفي به في الاستكشاف عن ملاحظة سائر الاقوال التي لها دخل فيه، فكيف إذا لم يكن كذلك.
ويلحظ أيضا سائر ما له تعلق في الاستكشاف بحسب ما يعتمد من تلك الاسباب، كما هو مقتضى الاجتهاد، سواء كان من الامور المعلومة أو المظنونة، و
من الاقوال المتقدمة على النقل أو المتأخرة أو المقارنة.
وربما يستغنى المتتبع بما ذكر عن الرجوع إلى كلام ناقل الاجماع لاستظهاره عدم مزية عليه في التتبع والنظر.
وربما كان الامر بالعكس وأنه إن تفرد بشئ كان نادارا لا يعتد به.
فعليه أن يستفرغ وسعه ويتبع نظره وتتبعه، سواء تأخر عن الناقل أم عاصره، وسواء أدى فكره إلى الموافقة له أو المخالفة، كما هو الشأن في معرفة سائر الادلة، وغيرها مما تعلق بالمسألة.
فليس الاجماع إلا كأحدها.
فالمقتضي للرجوع إلى النقل هو مظنة وصول الناقل إلى ما لم يصل هو إليه من جهة السبب أو إحتمال ذلك، فيعتمد عليه في هذا خاصة بحسب ما استظهر من حاله ونقله وزمانه ويصلح كلامه مؤيدا فيما عداه مع الموافقة لكشفه عن توافق النسخ وتقويته للنظر.
فإذا لوحظ جميع ما ذكر وعرف الموافق والمخالف إن وجد، فليفرض المظنون منه كالمعلوم، لثبوت حجيته بالدليل العملي ولو بوسائط.ثم لينظر.فإن حصل من ذلك إستكشاف معتبر كان حجة ظنية حيث كان متوقفا على النقل الغير الموجب للعلم بالسبب أو كان المنكشف غير الدليل القاطع، وإلا فلا.
وإذا تعدد ناقل الاجماع أو النقل، فإن توافق الجميع لوحظ كل ما علم على ما فصل وأخذ بالحاصل، وإن تخالف لوحظ جميع ما ذكر وأخذ فيما إختلف فيه النقل بالارجح بحسب حال الناقل وزمانه ووجود المعاضد وعدمه وقلته وكثرته.
ثم ليعمل بما هو المحصل ويحكم على تقدير حجيته بأنه دليل ظني واحد وإن توافق النقل وتعدد الناقل.
وليس ما ذكرناه مختصا بنقل الاجماع المتضمن لنقل الاقوال إجمالا، بل يجري في نقلها تفصيلا أيضا.
وكذلك في نقل سائر الاشياء التي يبتنى عليها معرفة الاحكام، والحكم فيما إذا وجد المنقول موافقا لما وجد أو مخالفا مشترك بين الجميع، كما هو ظاهر.
وقد إتضح بما بيناه وجه ما جرت عليه طريقة معظم الاصحاب مع عدم الاستدلال بالاجماع المنقول على وجه الاعتماد والاستقلال غالبا، ورده بعدم
الثبوت أو بوجدان الخلاف ونحوهما.
فإنه المتجه على ما قلنا، ولا سيما فيما شاع فيه النزاع والجدال إذ عرفت فيه الاقوال، أو كان من الفروع النادرة التي لا يستقيم فيها دعوى الاجماع، لقلة المتعرض لها إلا على بعض الوجوه التي لا يعتد بها، أو كان الناقل ممن لا يعتد بنقله، لمعاصرته أو قصور باعه أو غيرهما مما يأتي بيانه.
فالاحتياج إليه مختص بقليل من المسائل بالنسبة إلى قليل من العلماء ونادر من النقلة الافاضل) إنتهى كلامه، رفع مقامه.
لكنك خبير بأن هذه الفائدة للاجماع المنقول كالمعدومة، لان القدر الثابت من الاتفاق باخبار الناقل المستند إلى حسه ليس مما يستلزم عادة موافقة الامام، عليه السلام، وإن كان هذا الاتفاق لو ثبت لنا أمكن أن يحصل العلم بصدور مضمونه.
لكن ليس علة تامة لذلك، بل هو نظير إخبار عدد معين في كونه قد يوجب العلم بصدق خبرهم وقد لا يوجب، وليس أيضا مما يستلزم عادة وجود الدليل المعتبر حتى بالنسبة إلينا، لان إستناد كل بعض منهم إلى ما لا نراه دليلا، ليس أمرا مخالفا للعادة.
ألا ترى أنه ليس من البعيد أن يكون القدماء القائلون بنجاسة البئر، بعضهم قد إستند إلى دلالة الاخبار الظاهرة في ذلك مع عدم الظفر بما يعارضها، وبعضهم قد ظفر بالمعارض ولم يعمل به، لقصور سنده أو لكونه من الآحاد عنده أو لقصور دلالته أو لمعارضتة، لاخبار النجاسة و ترجيحها عليه بضرب من الترجيح.
فإذا ترجح في نظر المجتهد المتأخر أخبار الطهارة فلا يضره إتفاق القدماء على النجاسة المستند إلى الامور المختلفة المذكورة.
وبالجملة، فالانصاف - بعد التأمل وترك المسامحة بإبراز المظنون بصورة القطع، كما هو متعارف محصلي عصرنا - أن إتفاق من يمكن تحصيل فتاواهم على أمر، كما لا يستلزم عادة موافقة الامام، عليه السلام، كذلك لا يستلزم وجود دليل معتبر عند الكل من جهة أو من جهات شتى.
فلم يبق في المقام إلا أن يحصل المجتهد أمارات أخر من أقوال باقي العلماء وغيرها ليضيفها إلى ذلك، فيحصل من مجموع المحصل له والمنقول إليه الذي فرض بحكم المحصل من حيث وجوب العمل به تعبدا القطع في مرحلة الظاهر باللازم.
وهو قول الامام أو وجود دليل معتبر الذي هو أيضا يرجع إلى حكم الامام بهذا الحكم الظاهري المضمون لذلك الدليل، لكنه أيضا مبني على كون مجموع المنقول من
الاقوال والمحصل من الامارات ملزوما عاديا لقول الامام، عليه السلام، أو وجود الدليل المعتبر.
وإلا فلا معنى لتنزيل المنقول منزلة المحصل بأدلة حجية خبر الواحد، كما عرفت سابقا.
ومن ذلك ظهر أن ما ذكره هذا البعض ليس تفصيلا في مسألة حجية الاجماع المنقول، ولا قولا بحجيته في الجملة من حيث أنه إجماع منقول، وإنما يرجع محصله إلى أن الحاكي للاجماع يصدق فيما يخبره عن حس.
فإن فرض كون ما يخبره عن حسه ملازما، بنفسه أو بضميمة أمارات أخر، لصدور الحكم الواقعي أو مدلول الدليل المعتبر عند الكل، كانت حكايته حجة، لعموم أدلة حجية الخبر في المحسوسات، وإلا فلا.
وهذا يقول به كل من يقول بحجية الخبر الواحد في الجملة.
وقد إعترف بجريانه في نقل الشهرة وفتاوى آحاد العلماء.
* * *
ومن جيمع ما ذكرنا يظهر الكلام في المتواتر المنقول وأن نقل التواتر في خبر لا يثبت حجيته ولو قلنا بحجية خبر الواحد، لان التواتر صفة في الخبر تحصل باخبار جماعة تفيد العلم للسامع ويختلف عدده بإختلاف خصوصيات المقامات، وليس كل تواتر ثبت لشخص مما يستلزم في نفس الامر عادة تحقق المخبر به.
فإذا أخبر بالتواتر فقد اخبر باخبار جماعة أفاد له العلم بالواقع.
وقبول هذا الخبر لا يجدي شيئا، لان المفروض أن تحقق مضمون المتواتر ليس من لوازم إخبار الجماعة الثابت بخبر العادل.
نعم لو أخبر باخبار جماعة يستلزم عادة تحقق المخبر به - بأن يكون حصول العلم بالمخبر به لازم الحصول لاخبار الجماعة.
كأن أخبر مثلا باخبار ألف عادل أو أزيد بموت زيد وحضور جنازته - كان اللازم من قبول خبره الحكم بتحقق الملزوم وهو إخبار الجماعة، فيثبت اللازم وهو تحقق موت زيد.
إلا أن لازم من يعتمد على الاجماع المنقول وإن كان إخبار الناقل مستندا إلى حدس غير مستند إلى المبادى المحسوسة المستلزمة للمخبر به هو القول بحجية التواتر المنقول.
لكن ليعلم أن معنى قبول نقل التواتر، مثل الاخبار بتواتر موت زيد مثلا، يتصور على وجهين.
الاول: الحكم بثبوت الخبر المدعى تواتره، أعني موت زيد.
نظير حجية الاجماع المنقول بالنسبة إلى المسألة المدعى عليها الاجماع.
وهذا هو الذي ذكرنا أن الشرط في قبول خبر الواحد فيه كون ما أخبر به مستلزما عادة لوقوع متعلقه.
الثاني: الحكم بثبوت تواتر الخبر المذكور ليترتب على ذلك الخبر آثار المتواتر وأحكامه الشرعية.
كما إذا نذر أن يحفظ أو يكتب كل خبر متواتر.
ثم أحكام التواتر، منها: ما ثبت لما تواتر في الجملة ولو عند غير هذا الشخص، ومنها: ما ثبت لما تواتر بالنسبة إلى هذا الشخص.
ولا ينبغي الاشكال في أن مقتضى قبول نقل التواتر العمل به على الوجه الاول وأول وجهي الثاني، كما لا ينبغي الاشكال في عدم ترتب آثار تواتر المخبر به عند نفس الشخص.
ومن هنا يعلم أن الحكم بوجوب القراءة في الصلاة إن كان منوطا بكون المقروء قرآنا واقعيا قرأه النبي صلى الله عليه وآله، فلا إشكال في جواز الاعتماد على إخبار الشهيد، قدس سره، بتواتر القراءات الثلاث، أعني قراءة أبي جعفر وأخويه [ يعقوب وخلف ].
لكن بالشرط المتقدم، وهو كون ما أخبر به الشهيد من التواتر ملزوما عادة لتحقق القرآنية.
وكذا لا إشكال في الاعتماد من دون شرط، إن كان الحكم منوطا بالقرآن المتواتر في الجملة، فإنه قد ثبت تواتر تلك القراءات عند الشهيد باخباره.
وإن كان الحكم معلقا على القرآن المتواتر عند القاري أو مجتهده، فلا يجدي إخبار الشهيد بتواتر تلك القراءات.
وإلى أحد الاولين نظر حكم المحقق والشهيد الثانيين بجواز القراءة بتلك القراءات مستندا إلى أن الشهيد والعلامة، قدس سرهما، قد إدعيا تواترها وأن هذا لا يقصر عن نقل الاجماع، وإلى الثالث نظر صاحب المدارك وشيخه المقدس الاردبيلي قدس سرهما، حيث إعترضا على المحقق و الشهيد بأن هذا رجوع عن إشتراط التواتر في القراءة.
ولا يخلو نظرهما عن نظر، فتدبر، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
ومن جملة الظنون التي توهم حجيتها بالخصوص الشهرة في الفتوى الحاصلة بفتوى جل الفقهاء المعروفين، سواء كان في مقابلها فتوى غيرهم بخلاف، أم لم يعرف الخلاف والوفاق من غيرهم.
ثم إن المقصود هنا ليس التعرض لحكم الشهرة من حيث الحجية في الجملة، بل المقصود إبطال توهم كونها من الظنون الخاصة، وإلا فالقول بحجيتها من حيث إفادة المظنة بناء على دليل الانسداد غير بعيد.
ثم إن منشأ توهم كونها من الظنون الخاصة أمران: أحدهما: ما يظهر من بعض، من أن أدلة حجية خبر الواحد تدل على حجيته بمفهوم الموافقة، لانه ربما يحصل منها الظن الاقوى من الحاصل من خبر العادل.
وهذا خيال ضعيف تخيله بعض في بعض رسائله، ووقع نظيره من الشهيد الثاني في المسالك، حيث وجه حجية الشياع الظني بكون الظن الحاصل منه أقوى من الحاصل من شهادة العدلين.
ووجه الضعف: أن الاولوية الظنية أوهن بمراتب من الشهرة، فكيف يتمسك بها في حجيتها، مع أن الاولوية ممنوعة رأسا، للظن بل العلم بأن المناط والعلة في حجية الاصل ليس مجرد إفادة الظن.
وأضعف من ذلك تسمية هذه الاولوية في كلام ذلك البعض مفهوم الموافقة، مع أنه ما كان إستفادة حكم الفرع من الدليل اللفظي الدال على حكم الاصل، مثل قوله تعالى: (ولا تقل لهما أف).
الامر الثاني: دلالة مرفوعة زرارة ومقبولة عمر بن حنظلة على ذلك.
ففي الاولى: (قال زرارة: قلت: جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان، فبأيهما نعمل؟ قال: خذ بما إشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النادر.
قلت: يا سيدي ! إنهما معا مشهوران مأثوران عنكم.
قال: خذ بما يقوله أعدلهما)، الخبر.
بناء على أن المراد بالموصول مطلق المشهور، رواية كان أو فتوى، أو أن إناطة الحكم بالاشتهار تدل على إعتبار الشهرة في نفسها وإن لم تكن في الرواية.
وفي المقبولة، بعد فرض السائل تساوي الراويين في العدالة، قال عليه السلام: (ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه.
وإنما الامور ثلاثة، أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله ورسوله.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك.
فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات، ومن أخذ الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم.
قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم).
إلى آخر الرواية.
بناء على أن المراد بالمجمع عليه في الموضعين هو المشهور، بقرينة إطلاق المشهور عليه في قوله: (و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور).
فيكون في التعليل بقوله: (فإن المجمع عليه)، إلخ، دلالة على أن المشهور مطلقا مما يجب العمل به وإن كان مورد التعليل الشهرة في الرواية.
ومما يؤيد إرادة الشهرة من الاجماع أن المراد لو كان الاجماع الحقيقي لم يكن ريب في بطلان خلافه، مع أن الامام عليه السلام جعل مقابله مما فيه الريب.
ولكن في الاستدلال بالروايتين ما لا يخفى من الوهن: أما الاولى، فيرد عليها مضافا إلى ضعفها، حتى أنه ردها من ليس دأبه الخدشة في سند الروايات، كالمحدث البحراني - أن المراد بالموصول هو خصوص الرواية المشهورة من الروايتين دون مطلق الحكم المشهور.
ألا ترى أنك لو سئلت عن أن أي المسجدين أحب إليك، فقلت: ما كان الاجتماع فيه أكثر.
لم يحسن للمخاطب أن ينسب إليك محبوبية كل مكان يكون الاجتماع فيه
أكثر بيتا كان أو خانا أو سوقا.
وكذا لو أجبت عن سؤال المرجح لاحد الرمانين فقلت: ما كان أكبر.
والحاصل: أن دعوى العموم في المقام بغير الرواية مما لا يظن بأدنى التفات، مع أن الشهرة الفتوائية مما لا يقبل أن يكون في طرفي المسألة.
فقوله: (يا سيدي ! إنهما معا مشهوران مأثوران)، أوضح شاهد على أن المراد بالشهرة الشهرة في الرواية الحاصلة بكون الرواية مما اتفق الكل على روايته أو تدوينه.
وهذا مما يمكن إتصاف الروايتين المتعارضين به.
ومن هنا يعلم الجواب عن التمسك بالمقبولة وأنه لا تنافي بين إطلاق المجمع عليه على المشهور و بالعكس حتى تصرف أحدهما عن ظاهره بقرينة الاخر، فإن إطلاق المشهور في مقابل الاجماع إنما هو إطلاق حادث مختص بالاصوليين، وإلا فالمشهور هو الواضح المعروف.
ومنه: شهر فلان سيفه، وسيف شاهر.
فالمراد أنه يؤخذ بالرواية التي يعرفها جميع أصحابك ولا ينكرها أحد منهم ويترك ما لا يعرفه إلا الشاذ ولا يعرفها الباقي.
فالشاذ مشارك للمشهور في معرفة الرواية المشهورة، والمشهور لا يشارك الشاذ في معرفة الرواية الشاذة.
ولهذا كانت الرواية المشهورة من قبيل بين الرشد، والشاذ من قبيل المشكل الذي يرد علمه إلى أهله، وإلا فلا معنى للاستشهاد بحديث التثليث.
ومما يضحكم الثكلى في هذا المقام توجيه قوله: (هما معا مشهوران)، بإمكان إنعقاد الشهرة في عصر على فتوى وفي عصر آخر على خلافها، كما قد يتفق بين القدماء والمتأخرين، فتدبر.
ومن جملة الظنون الخارجة بالخصوص عن أصالة حرمة العمل بغير العلم خبر الواحد في الجملة عند المشهور بل كاد أن يكون إجماعا.
إعلم أن إثبات الحكم الشرعي بالاخبار المروية عن الحجج، عليهم السلام، موقوف على مقدمات ثلاث: الاولى كون الكلام صادرا عن الحجة.
الثانية كون صدوره لبيان حكم الله، لا على وجه آخر من تقية وغيرها.
الثالثة ثبوت دلالتها على الحكم المدعى.
وهذا يتوقف أولا على تعيين أوضاع ألفاظ الرواية، و ثانيا على تعيين المراد منها وأن المراد مقتضى وضعها أو غيره.
فهذه أمور أربعة.
وقد أشرنا إلى كون الجهة الثانية من (المقدمة الثالثة) من الظنون الخاصة وهو المعبر عنه بالظهور اللفظي، وإلى أن الجهة الاولى منها مما لم يثبت كون الظن الحاصل فيها بقول اللغوى من الظنون الخاصة وإن لم نستبعد الحجية أخيرا.
وأما (المقدمة الثانية)، فهي أيضا ثابتة بأصالة عدم صدور الرواية لغير داعي بيان الحكم الواقعي.
وهي حجة، لرجوعها إلى القاعدة المجمع عليها بين العلماء والعقلاء من حمل كلام المتكلم على كونه صادرا لبيان مطلوبه الواقعي، لا لبيان خلاف مقصوده من تقية أو خوف، ولذا لا يسمع دعواه ممن يدعيه إذا لم يكن كلامه محفوفا بأماراته.
أما (المقدمة الاولى)، فهي التي عقد لها مسألة حجية أخبار الآحاد.
فمرجع هذه المسألة إلى أن السنة، أعني قول الحجة أو فعله أو تقريره، هل تثبت بخبر الواحد أم لا تثبت إلا بما يفيد القطع من التواتر والقرينة.
ومن هنا يتضح دخولها في مسائل أصول الفقه الباحثة عن أحوال الادلة.
ولا حاجة إلى تجشم دعوى أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل.
ثم اعلم أن أصل وجوب العمل بالاخبار المدونة في الكتب المعروفة مما أجمع عليه في هذه الاعصار، بل لا يبعد كونه ضروري المذهب.
وإنما الخلاف في مقامين: أحدهما: كونها مقطوعة الصدور أو غير مقطوعة.
فقد ذهب شرذمة من متأخري الاخباريين، فيما نسب إليهم، إلى كونها قطعية الصدور.
وهذا قول لا فائده في بيانه والجواب عنه إلا التحرز عن حصول هذا الوهم لغيرهم كما حصل لهم، وإلا فمدعي القطع لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه.
وقد كتبنا في سالف الزمان في رد القول رسالة تعرضنا فيها لجميع ما ذكروه وبيان ضعفها بحسب ما أدى إليه فهمي القاصر.
الثاني: أنها مع عدم قطعية صدورها معتبرة بالخصوص أم لا.
فالمحكي عن السيد والقاضي وإبن زهرة والطبرسي وإبن إدريس، قدس الله أسرارهم، المنع.
وربما نسب إلى المفيد، قدس سره، حيث حكي عنه في المعارج أنه قال: (إن خبر الواحد القاطع للعذر، هو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالنظر إلى العلم، وربما يكون ذلك إجماعا أو شاهدا من عقل).
وربما ينسب إلى الشيخ، كما سيجئ عند نقل كلامه، وكذا إلى المحقق، بل إلى إبن بابويه، بل في الوافية: (أنه لم يجد القول بالحجية صريحا ممن تقدم على العلامة)، وهو عجيب.
وأما القائلون بالاعتبار فهم مختلفون، من جهة أن المعتبر منها كل ما في الكتب الاربعة، كما يحكى عن بعض الاخباريين أيضا، وتبعهم بعض المعاصرين من الاصوليين بعد إستثناء ما كان مخالفا للمشهور، أو أن المعتبر بعضها وأن المناط في الاعتبار عمل الاصحاب كما يظهر من كلام المحقق، أو عدالة الراوي أو وثاقته أو مجرد الظن بصدور الرواية من غير إعتبار صفة في الراوي، أو غير ذلك من الفصيلات في الاخبار.
والمقصود هنا بيان إثبات حجيته بالخصوص في الجملة في مقابل السلب الكلي.
ولنذكر، أولا، ما يمكن أن يحتج به القائلون بالمنع، ثم نعقبه بذكر أدلة الجواز فنقول:
أما حجية المانعين، فالادلة الثلاثة أما الكتاب: فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم والتعليل المذكور في آية النباء، على ما ذكره أمين الاسلام، من أن فيها دلالة على عدم جواز العمل بخبر الواحد.
وأما السنة: فهي أخبار كثيرة تدل على المنع من العمل بالخبر الغير المعلوم الصدور إلا إذا احتف بقرينة معتبرة من كتاب او سنة معلومة: مثل ما رواه في البحار عن بصائر الدرجات، عن محمد بن عيسى، قال: (أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام وجوابه عليه السلام بخطه، فكتب: نسألك عن العلم المنقول عن آبائك وأجدادك، صلوات الله عليهم أجمعين، قد إختلفوا علينا فيه، فكيف العمل به على إختلافه؟ فكتب، عليه السلام، بخطه: ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموه فردوه إلينا).
ومثله عن مستطرفات السرائر.
والاخبار الدالة على عدم جواز العمل بالخبر المأثور إلا إذا وجد له شاهد من كتاب الله أو من السنة المعلومة، فتدل على المنع عن العمل بالخبر الواحد المجرد عن القرينة: مثل ما ورد في غير واحد من الاخبار أن النبي، صلى الله عليه وآله، قال: (ما جاءكم عني مما لا يوافق القرآن فلم أقله).
وقول أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام: (لا يصدق علينا إلا ما يوافق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله).
وقوله عليه السلام: (إذا جاءكم حديث عنا فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به وإلا فقفوا عنده ثم ردوه إلينا حتى نبين لكم).
ورواية إبن أبي يعفور قال: (سالت أبا عبدالله عليه السلام عن إختلاف الحديث، يرويه من نثق به ومن لا نثق به.
قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله فخذوا به، وإلا فالذى جاءكم به أولى به) وقوله عليه السلام لمحمد بن مسلم: (ما جاءكم من رواية من بر أو فاجر يوافق كتاب الله فخذ به وما جاءكم من رواية بر أو فاجر يخالف كتاب الله فلا تأخذ به).
وقوله عليه السلام: (ما جاءكم من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل).
وقول أبي جعفر عليه السلام: (ما جاءكم عنا فإن وجدتموه موافقا للقرآن فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقا فردوه، وإن اشتبه الامر عندكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح من ذلك ما شرح لنا).
وقول الصادق عليه السلام: (كل شئ مردود إلى كتاب الله والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف).
وصحيحة هشام بن الحكم عن ابي عبدالله عليه السلام: (ولا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق الكتاب والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد - لعنه الله دس - في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي.فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا).
والاخبار الواردة في طرح الاخبار المخالفة للكتاب والسنة ولو مع عدم المعارض متواترة جدا.
وجه الاستدلال بها: أن من الواضحات أن الاخبار الواردة عنهم، صلوات الله عليهم في مخالفة ظواهر الكتاب و السنة في غاية الكثرة.
والمراد من المخالفة للكتاب في تلك الاخبار الناهية عن الاخذ بمخالفة الكتاب والسنة ليست هي المخالفة على وجه التباين الكلي بحيث يتعذر أو يتعسر الجمع، إذ لا يصدر من الكذابين عليهم ما يباين الكتاب والسنة كلية، إذا لا يصدقهم أحد في ذلك.
فما كان يصدر عن الكذابين من الكذب لم يكن إلا نظير ما كان يرد من الائمة، صلوات الله عليهم، في مخالفة ظواهر الكتاب والسنة.
فليس المقصود من عرض ما يرد من الحديث على الكتاب والسنة إلا عرض
ما كان منها غير معلوم الصدور عنهم، وأنه إن وجد له قرينة وشاهد معتمد فهو، وإلا فليتوقف فيه، لعدم إفادته العلم بنفسه وعدم إعتضاده بقرينة معتبرة.
ثم إن عدم ذكر الاجماع ودليل العقل من جملة قرائن الخبر في هذه الروايات، كما فعله الشيخ في العدة، لان مرجعهما إلى الكتاب والسنة، كما يظهر بالتأمل.
ويشير إلى ما ذكرنا، من أن المقصود من عرض الخبر على الكتاب والسنة هو في غير معلوم الصدور، تعليل العرض في بعض الاخبار بوجود الاخبار المكذوبة في أخبار الامامية.
وأما الاجماع: فقد إدعاه السيد المرتضى، قدس سره، في مواضع من كلامه، وجعله في بعضها بمنزلة القياس في كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة.
وقد إعترف بذلك الشيخ، على ما يأتي في كلامه، إلا أنه أول معقد الاجماع بإرادة الاخبار التي يرويها المخالفون.
وهو ظاهر المحكي عن الطبرسي في مجمع البيان، قال: (لا يجوز العمل بالظن عند الامامية إلا في شهادة العدلين وقيم المتلفات وأروش الجنايات)، إنتهى.
والجواب: أما عن الآيات فبأنها، بعد تسليم دلالتها، عمومات مخصصة بماسيجئ من الادلة.
وأما [ الجواب ] عن الاخبار فعن الرواية الاولى فبأنها خبر واحد لا يجوز الاستدلال بها على المنع عن الخبر الواحد.
وأما أخبار العرض على الكتاب، فهي وإن كانت متواترة بالمعنى إلا أنها بين طائفتين، إحداهما ما دل على طرح الخبر الذي يخالف الكتاب، والثانية ما دل على طرح الخبر الذي لا يوافق الكتاب.
أما الطائفة الاولى، فلا تدل على المنع عن الخبر الذي لا يوجد مضمونه في الكتاب والسنة.
فإن قلت: ما من واقعة إلا ويمكن إستفادة حكمها من عمومات الكتاب المقتصر في تخصيصها على السنة القطعية.
مثل قوله تعالى: (خلق لكم ما في الارض جميعا).
وقوله تعالى: (إنما حرم عليكم الميتة)، إلخ.
و (كلوا مما غنمتم حلالا طيبا)، و (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم
العسر)، ونحو ذلك فالاخبار المخصصة لها كلها وكثير من عمومات السنة القطعية مخالفة للكتاب والسنة.
قلت: أولا، إنه لا يعد مخالفة ظاهر العموم، خصوصا مثل هذه العمومات، مخالفة، وإلا لعدت الاخبار الصادرة يقينا عن الائمة، عليهم السلامم المخالفة لعمومات الكتاب والسنة مخالفة للكتاب والسنة.
غاية الامر ثبوت الاخذ بها مع مخالفتها بكتاب الله وسنة نبيه، صلى الله عليه وآله، فتخرج عن عموم أخبار العرض.
مع أن الناظر في أخبار العرض على الكتاب والسنة يقطع بأنها تأبى عن التخصيص.
وكيف يرتكب التخصيص في قوله عليه السلام: (كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف)، وقوله: (ما أتاكم من حديث لا يوافق كتاب الله فهو باطل)، وقوله عليه السلام: (لا تقبلوا علينا خلاف القرآن، فإنا إن حدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة)، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (ما خالف كتاب الله فليس من حديثي، أو، لم أقله)، مع أن أكثر عمومات الكتاب قد خصص بقول النبي صلى الله عليه وآله.
ومما يدل، على أن المخالفة لتلك العمومات لا تعد مخالفة، لما دل من الاخبار على بيان حكم ما لا يوجد حكمه في الكتاب والسنة النبوية، إذ بناء على تلك العمومات لا يوجد واقعة لا يوجد حكمها فيهما.
فمن تلك الاخبار: ما عن البصائر والاحتجاج وغيرهما مرسلة عن رسول الله " ص " أنه قال: (ما وجدتم في كتاب الله فالعمل به لازم، ولا عذر لكم في تركه، وما لم يكن في كتاب الله تعالى وكانت فيه سنة مني فلا عذر لكم في ترك سنتي، وما لم يكن فيه سنة مني.
فما قال أصحابي فقولوا به، فإنما مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم، بأيها أخذ اهتدي، وبأي أقاويل أصحابي أخذتم إهتديتم.وإختلاف أصحابي رحمة لكم.
قيل: يا رسول الله، ومن أصحابك قال: أهل بيتي)، الخبر.
فإنه صريح في أنه قد يرد من الائمة، عليهم السلام، ما لا يوجد في الكتاب والسنة.
ومنها: ما ورد في تعارض الروايتين من رد ما لا يوجد في الكتاب والسنة إلى الائمة، عليهم السلام، مثل ما رواه في العيون عن أبي الوليد، عن سعد بن محمد بن عبدالله المسمعي، عن
الميثمي.
وفيها: (ما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله - إلى أن قال: - وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله صلى الله عليه وآله - إلى أن قال - وما لم تجدوه في شئ من هذه فردوه إلينا علمه، فنحن أولى بذلك)، الخبر.
والحاصل: أن القرائن الدالة على أن المراد بمخالفة الكتاب ليس مجرد مخالفة عمومه أو إطلاقه كثيرة تظره لمن له أدنى تتبع.
ومن هنا ضعف التأمل في تخصيص الكتاب بخبر الواحد لتلك الاخبار، بل منعه لاجلها، كما عن الشيخ في العدة، أو لما ذكره المحقق من أن الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد الاجماع على إستعماله فيما لا يوجد فيه دلالة، ومع الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به.
وثانيا، أنا نتكلم في الاحكام التي لم يرد فيها عموم من القرآن والسنة، ككثير من أحكام المعاملات، بل العبادات التي لم ترد فيها إلا آيات مجملة أو مطلقة من الكتاب.
إذ لو سلمنا أن تخصيص العموم يعد مخالفة، أما تقييد المطلق فلا يعد في العرف مخالفة، بل هو مفسر خصوصا على المختار من عدم كون المطلق مجازاعند التقييد.
فإن قلت: فعلى أي شئ تحمل تلك الاخبار الكثيرة الآمرة بطرح مخالف الكتاب؟ فإن حملها على طرح مكا يباين الكتاب كلية حمل على فرد نادر بل معدوم، فلا ينبغي لاجله هذا الاهتمام الذي عرفته في الاخبار.
قلت: هذه الاخبار على قسمين: منها: ما يدل على عدم صدور الخبر المخالف للكتاب والسنة عنهم، عليهم السلام، وأن المخالف لهما باطل، وأنه ليس بحديثهم.
ومنها: ما يدل على عدم جواز تصديق الخبر المحكي عنهم، عليهم السلام، إذا خالف الكتاب والسنة.
أما الطائفة الاولى، فالاقرب حملها على الاخبار الواردة في أصول الدين، مثل مسائل الغلو والجبر والتفويض التي ورد فيها الآيات والاخبار النبوية.
وهذه الاخبار غير موجودة في كتبنا الجوامع، لانها أخذت عن الاصول بعد تهذيبها من تلك الاخبار.
وأما الثانية، فيمكن حملها على ما ذكر في الاولى، ويمكن حملها على صورة تعارض الخبرين كما يشهد به مورد بعضها، ويمكن حملها على خبر غير الثقة، لما سيجئ من الادلة على إعتبار خبر الثقة.
هذا كله في الطائفة الدالة على طرح الاخبار المخالفة للكتاب والسنة.
وأما الطائفة الآمرة بطرح ما لا يوافق الكتاب أو لم يوجد عليه شاهد من الكتاب والسنة.
فالجواب عنها - بعد ما عرفت من القطع بصدور الاخبار الغير الموافقة لما يوجد في الكتاب منهم، عليهم السلام، كما دل عليه روايتا الاحتجاج والعيون المتقدمتان المعتضدتان بغيرهما من الاخبار - انها محمولة على ما تقدم في الطائفة الآمرة بطرح الاخبار المخالفة للكتاب والسنة، وأن ما دل منها على بطلان ما لم يوافق وكونه زخرفا محمول على الاخبار الواردة في أصول الدين، مع إحتمال كون ذلك من أخبارهم الموافقة للكتاب والسنة على الباطن الذي يعلمونه منها، ولهذا كانوا يستشهدون كثيرا بآيات لا نفهم دلالتها، وما دل على عدم جواز تصديق الخبر الذي لا يوجد عليه شاهد من كتاب الله على خبر غير الثقة أو صورة التعارض، كما هو ظار غير واحد من الاخبار العلاجية.
ثم إن الاخبار المذكورة على فرض تسليم دلالتها وإن كانت كثيرة إلا أنها لا تقاوم الادلة الاتية، فإنها موجبة للقطع بحجية خبر الثقة، فلا بد من مخالفة الظاهر في هذه الاخبار.
وأما الجواب عن الاجماع: الذي إدعاه السيد والطبرسي، قدس سرهما، فبأنه لم يتحقق لنا هذا الاجماع.
والاعتماد على نقله تعويل على خبر الواحد، مع معارضته بما سيجئ من دعوى الشيخ المعتضده بدعوى جماعة أخرى الاجماع عليه حجية خبر الواحد في الجملة، وتحقق الشهرة على خلافها بين القدماء والمتأخرين.
وأما نسبة بعض العامة، كالحاجبي والعضدي، عدم الحجية إلى الرافضة، فمستندة إلى ما رأوا من السيد من دعوى الاجماع بل ضرورة المذهب على كون خبر الواحد كالقياس عند الشيعة.
وأما المجوزون، فقد إستدلوا على حجيته بالادلة الاربعة أما الكتاب، فقد ذكروا منه آيات إدعوا دلالتها منها: قوله تعالى في سورة الحجرات: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين).
والمحكي في وجه الاستدلال بها وجهان: أحدهما: أنه سبحانه علق وجوب التثبت على مجئ الفاسق فينتفي عند إنتفائه عملا بمفهوم الشرط.
واذا لم يجب التثبت عند مجئ غير الفاسق، فاما أن يجب القبول وهو المطلوب، أو الرد وهو باطل، لانه يقتضي كون العادل أسوء حالا من الفاسق، وفساده بين.
الثاني: أنه تعالى أمر بالتثبت عند إخبار الفاسق.
وقد إجتمع فيه وصفان، ذاتي وهو كونه خبر واحد، وعرضي وهو كونه خبر فاسق.
ومقتضى التثبت هو الثاني، للمناسبة والاقتران، فإن الفسق يناسب عدم القبول، فلا يصلح الاول للعلية، وإلا لوجب الاستناد إليه.
إذ التعليل بالذاتي الصالح للعلية أولى من التعليل بالعرضي، لحصوله قبل حصول العرضي، فيكون الحكم قد حصل قبل حصول العرضي.
وإذا لم يجب التثبت عند إخبار العدل، فإما أن يجب القبول وهو المطلوب، أو الرد، فيكون حاله أسوء من حال الفاسق، وهو محال.
أقول: الظاهر أن أخذهم للمقدمة الاخيرة - وهي أنه إذا لم يجب التثبت وجب القبول، لان الرد مستلزم لكون العادل أسوء حالا من الفاسق - مبني عى ما يتراءى من ظهور الامر بالتبين في الوجوب النفسي، فيكون هنا أمور ثلاثة، الفحص عن الصدق والكذب، والرد من دون تبين، والقبول
كذلك.لكنك خبير بأن الامر بالتبين هنا مسوق لبيان الوجوب الشرطي وأن التبين شرط للعمل بخبر الفاسق دونالعادل.
فالعمل بخبر العادل غير مشروط بالتبين، فيتم المطلوب من دون ضم مقدمة خارجية، وهي كون العادل أسوء حالا من الفاسق.
والدليل على كون الامر التبين للوجوب الشرطي لا النفسي - مضافا إلى أنه المتبادر عرفا في أمثال المقام وإلى أن الاجماع قائم على عدم ثبوت الوجوب النفسي للتبين في خبر الفاسق، وإنما أوجبه من أوجبه عند إرادة العمل به، لا مطلقا - هو أن التعليل في الاية بقوله تعالى: (أن تصيبوا)، لا يصلح أن يكون تعليلا للوجوب النفسي، لان حاصله يرجع إلى أنه: (لئلا تصيبوا قوما بجهالة بمقتضى العمل بخبر الفاسق فتندموا على فعلكم بعد تبين الخلاف).
ومن المعلوم أن هذا لا يصلح إلا علة لحرمة العمل بدون التبين.
فهذا هو المعلول، ومفهومه جواز العمل بخبر العادل من دون تبين.
مع أن في الاسوئية المذكورة في كلام الجماعة، بناء على كون وجوب التبين نفسيا، ما لا يخفى، لان الاية على هذا ساكتة عن حكم العمل بخبر الواحد قبل التبين وبعده، فيجوز إشتراك الفاسق والعادل في عدم جواز العمل قبل التبين، كما أنهما يشتركان قطعا في جواز العمل بعد التبين والعلم بالصدق، لان العمل حينئذ بمقتضى التبين لا بإعتبار الخبر.
فاختصاص الفاسق بوجوب التعرض بخبره والتفتيش عنه دون العادل لا يستلزم كون العادل أسوء حال، بل مستلزم لمزية كاملة للعادل على الفاسق، فتأمل.
* * *
وكيف كان، فقد أورد على الآية إيرادات كثيرة ربما تبلغ إلى نيف وعشرين، إلا أن كثيرا منها قابلة للدفع، فلنذكر، أولا ما لا يمكن الذب عنه، ثم نتبعه بذكر بعض ما أورد من الايرادات القابلة للدفع.
أما ما لا يمكن الذب عنه فايرادان أحدهما: أن الاستدلال إن كان راجعا إلى إعتبار مفهوم الوصف أعني الفسق، ففيه: أن المحقق في محله عدم إعتبار المفهوم في الوصف، خصوصا في الوصف الغير المعتمد على موصوف محقق، كما
فيما نحن فيه، فإنه أشبه بمفهوم اللقب.
ولعل هذا مراد من أجاب عن الآية، كالسيدين وأمين الاسلام والمحقق والعلامة وغيرهم، بأن هذا الاستدلال مبني على دلايل الخطاب ولانقول به.
وإن كان بإعتبار مفهوم الشرط، كما يظهر من المعالم والمحكي عن جماعة، ففيه: أن مفهوم الشرط عدم مجئ الفاسق بالنبأ، وعدم التبين هنا لاجل عدم ما يتبين.
فالجملة الشرطية هنا مسوقة لبيان تحقق الموضوع، كما في قول القائل: إن رزقت ولدا فاختنه، وإن ركب زيد فخذ ركابه، وإن قدم من السفر فاستقبله، وإن تزوجت فلا تضيع حقك زوجتك، وإذا قرأت الدرس فاحفظه.
قال الله سبحانه: و (إذا قرء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا)، و: (إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها)، إلى غير ذلك مما لا يحصى.
ومما ذكرنا ظهر فساد ما يقال: تارة إن عدم مجئ الفاسق يشمل ما لو جاء العادل بنبأ فلا يجب تبينه فيثبت المطلوب، وأخرى إن جعل مدلول الاية هو عدم وجوب التبين في خبر الفاسق لاجل عدمه، يوجب حمل السالبة على المنتفية بإنتفاء الموضوع، وهو خلاف الظاهر.
وجه الفساد: أن الحكم إذا ثبت لخبر الفاسق بشرط مجئ الفاسق به كان المفهوم بحسب الدلالة العرفية أو العقلية إنتفاء الحكم المذكور في المنطوق عن الموضوع المذكور فيه عند إنتفاء الشرط المذكور فيه.
ففرض مجئ العادل بنبأ عند عدم الشرط - وهو مجئ الفاسق بالنبأ - لا يوجب إنتفاء التبين عن خبر العادل الذي جاء به، لانه لم يكن مثبتا في المنطوق حتى ينفى في المفهوم.
فالمفهوم في الاية أمثالها ليس قابلا لغير السالبة بإنتفاء الموضوع، وليس هنا قضية لفظية سالبة دار الامر بين كون سلبها لسلب المحمول عن الموضوع الموجود أو لانتفاء الموضوع.
الثاني: ما أورده، في محكي العدة والذريعة والغنية ومجمع البيان والمعارج وغيرها، من أنا لو سلمنا دلالة المفهوم على قبول خبر العادل الغير المفيد للعلم، لكن نقول: إن مقتضى عموم التعليل وجوب التبين في كل خبر لا يؤمن الوقوع في الندم من العمل به وإن كان المخبر عادلا، فيعارض المفهوم والترجيح مع ظهور التعليل.
لا يقال إن النسبة بينهما وإن كان عموما من وجه، فتعارضان في مادة الاجتماع وهي خبر العادل الغير المفيد للعلم، لكن يجب تقديم عموم المفهوم وإدخال مادة الاجتماع فيه، إذ لو خرج عنه وانحصر مورده في خبر العادل المفيد للعلم كان لغوا، لان خبر الفاسق المفيد للعلم أيضا واجب
العمل، بل الخبر المفيد للعلم خارج عن المنطوق والمفهوم معا، فيكون المفهوم أخص مطلقا من عموم التعليل.
لانا نقول: ما ذكره أخيرا من أن المفهوم أخص مطلقا من عموم التعليل مسلم، إلا أنا ندعي التعارض بين ظهور عموم التعليل في عدم جواز العمل بخبر العادل الغير العلمي وظهور الجملة الشرطية أو الوصفية في ثبوت المفهوم.
فطرح المفهوم والحكم بخلو الجملة الشرطية عن المفهوم أولى من إرتكاب التخصيص في التعليل.
وإليه أشار في محكي العدة بقوله: (لا نمنع ترك دليل الخطاب لدليل، والتعليل دليل).
وليس في ذلك منافاة لما هو الحق، وعليه الاكثر، من جواز تخصيص العام بمفهوم المخالفة، لاختصاص ذلك أولا بالمخصص المنفصل.
ولو سلم جريانه في الكلام الواحد منعناه في العلة و المعلول، فإن الظاهر عند العرف أن المعلول يتبع العلة في العموم والخصوص.فالعلة تارة تخصص مورد المعلول وإن كان عاما بحسب اللفظ.
كما في قول القائل: (لا تأكل الرمان لانه حامض)، فيخصصه بالافراد الحامضة.
فيكون عدم التقييد في الرمان لغلبة الحموضة فيه.
وقد توجب عموم المعلول وإن كان بحسب الدلالة اللفظية خاصا، كما في قولن القائل: (لا تشرب الادوية التي يصفها لك النسوان، أو إذا وصفت لك إمرأه دواء فلا تشربه، لانك لا تأمن ضرره).
فيدل على أن الحكم عام في كل دواء لا يؤمن ضرره من أي واصف كان، ويكون تخصيص النسوان بالذكر من بين الجهال لنكتة خاصة أو عامة لاحظها المتكلم.
وما نحن فيه من هذا القبيل، فلعل النكتة فيه التنبيه على فسق الوليد، كما نبه عليه في المعارج.
وهذا الايراد مبني على أن المراد بالتبين هو التبين العلمي كما هو متقضى إشتقاقه.
ويمكن أن يقال: إن المراد منه ما يعم الظهور العرفي الحاصل من الاطمينان الذي هو مقابل الجهالة.
وهذا، وإن كان يدفع الايراد المذكور عن المفهوم - من حيث رجوع الفرق بين الفاسق والعادل في وجوب التبين إلى أن العادل الواقعي يحصل منه غالبا الاطمينان المذكور بخلاف
الفاسق، فلهذا وجب فيه تحصيل الاطمينان من الخارج - لكنك خبير بأن الاستدلال بالمفهوم على حجية الخبر العادل المفيد للاطمينان غير محتاج إليه، إذ المنطوق على هذا التقرير يدل على حجية كل ما يفيد الاطمينان، كما لا يخفى، فيثبت إعتبار مرتبة خاصة من مطلق الظن.
ثم إن المحكي عن بعض منع دلالة التعليل على عدم جواز الاقدام على ما هو مخالف للواقع: بأن المراد بالجهالة السفهاة وفعل ما لا يجوز فعله، لا مقابل العلم، بدليل قوله تعالى: (فتصبحوا على ما فعلتم نادمين).
ولو كان المراد الغلط في الاعتقاد لما جاز الاعتماد على الشهادة والفتوى.
وفيه، مضافا إلى كونه خلاف ظاهر لفظ الجهالة: أن الاقدام على مقتضى قول الوليد لم يكن سفاهة قطعا، إذ العاقل بل جماعة من العقلاء لا يقدمون على الامور من دون وثوق بخبر المخبر بها فالاية تدل على المنع عن العمل بغير العلم، لعلة هي كونه في معرض المخالفة للواقع.
وأما جواز الاعتماد على الفتوى والشهادة، فلا يجوز القياس بها، لما تقدم في توجيه كلام إبن قبة، من أن الاقدام على ما فيه مخالفة الواقع أحيانا: قد يحسن لاجل الاضطرار إليه وعدم وجود الاقرب إلى الواقع منه، كما في الفتوى، وقد يكون لاجل مصلحة تزيد على مصلحة إدراك الواقع، فراجع.
فالاولى لمن يريد التفصي عن هذا الايراد التشبث بما ذكرنا، من أن المراد بالتبين تحصيل الاطمينان، وبالجهالة الشك أو الظن الابتدائي الزائل بعد الدقة والتأمل، فتأمل.
ففيها إرشاد إلى عدم جواز مقايسة الفاسق بغيره وإن حصل منه الاطمينان، لان الاطمينان الحاصل من الفاسق يزول بالالتفات إلى فسقه وعدم مبالاته بالمعصية وإن كان متحرزا عن الكذب.
ومنه: يظهر الجواب عما ربما يقال من: أن العاقل لا يقبل الخبر من دون إطمينان بمضمونه، عادلا كان المخبر أو فاسقا.فلا وجه للامر بتحصيل الاطمينان في الفاسق.
وأما ما أورد على الاية بما هوقابل للذب عنه فكثير منها: معارضة مفهوم الاية بالايات الناهية عن العمل بغير العلم، والنسبة عموم من وجه، فالمرجع إلى أصالة عدم الحجية.
وفيه: أن المراد بالنبأ في المنطوق ما لا يعلم صدقه ولا كذبه.
فالمفهوم أخص مطلقا من تلك الايات فيتعين تخصيصها، بناء على ما تقرر، من أن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم أقوى من ظهور العام في العموم.
وأما منع ذلك فيما تقدم من التعارض بين عموم التعليل وظهور المفهوم، فلما
عرفت من منع ظهور الجملة الشرطية المعللة بالتعليل الجاري في صورتي وجود الشرط وإنتفائه في إفادة الانتفاء عند الانتفاء، فراجع.
وربما يتوهم: أن للايات الناهية جهة خصوص، إما من جهة إختصاصها بصورة التمكن من العلم، وإما من جهة اختصاصها بغير البينة العادلة وأمثالها مما خرج عن تلك الايات قطعا.
ويندفع:
الاول، بعد منع الاختصاص، بأنه يكفي المستدل كون الخبر حجة بالخصوص عند الانسداد.
والثاني بأن خروج ما خرج من أدلة حرمة العمل بالظن لا يوجب جهة عموم في المفهوم، لان المفهوم أيضا دليل خاص، مثل الخاص الذي خصص أدلة حرمة العمل بالظن، فلا يجوز تخصيص العام بأحدهما أولا ثم ملاحظة النسبة بين العام بعد ذلك التخصيص وبين الخاص الاخير.
فإذا ورد: (أكرم العلماء)، ثم قام الدليل على عدم وجوب إكرام جماعة من فساقهم، ثم ورد دليل ثالث على عدم وجوب إكرام مطلق الفساق منهم، فلا مجال لتوهم تخصيص العام بالخاص الاول أولا، ثم جعل النسبة بينه وبين الخاص الثاني عموما من وجه، وهذا أمر واضح نبهنا عليه في (باب التعارض).
ومنها: أن مفهوم الاية لو دل على حجية خبر العادل لدل على حجية الاجماع الذي أخبر به السيد المرتضى وأتباعه، قدست أسرارهم، من عدم حجية خبر العادل، لانهم عدول أخبروا بحكم الامام، عليه السلام، بعدم حجية الخبر.
وفساد هذا الايراد أوضح من أن يبين، إذ بعد الغض عما ذكرنا سابقا في عدم شمول اية النبأ للاجماع المنقول، وبعد الغض عن أن إخبار هؤلاء معارض بإخبار الشيخ، قدس سره، نقول: إنه لا يمكن دخول هذا الخبر تحت الاية.
أما أولا، فلان دخوله يسلتزم خروجه، لانه خبر العادل فيستحيل دخوله.
ودعوى أنه لا يعم نفسه مدفوعة بأنه وإن لا يعم نفسه، لقصور دلالة اللفظ عليه، إلا أنه يعلم أن الحكم ثابت لهذا الفرد أيضا، للعلم بعدم خصوصية مخرجة له عن الحكم.
ولذا لو سألنا السيد عن أنه إذا ثبت إجماعك لنا بخبر واحد هل يجوز الاتكال عليه، فيقول: لا.
وأما ثانيا، فلو سلمنا جواز دخوله، لكن نقول إنه وقع الاجماع على خروجه من النافين بحجية الخبر ومن المثبتين، فتأمل.
وأما ثالثا، فلدوران الامر بين دخوله وخروج ما عداه وبين العكس، ولا ريب أن العكس
متعين، لا مجرد قبح إنتهاء التخصيص إلى الواحد، بل لان المقصود من الكلام حينئذ ينحصر في بيان عدم حجية خبر العادل.
ولا ريب أن التعبير عن هذا المقصود بما يدل على عموم حجية خبر العادل قبيح في الغاية وفضيح إلى النهاية.
كما يعلم من قول القائل: (صدق زيدا في جميع ما يخبرك)، فأخبرك زيد بألف من الاخبار، ثم أخبر بكذب جميعها، فأراد القائل من قوله: (صدق، إلخ) خصوص هذا الخبر.
وقد أجاب بعض من لا تحصيل له: بأن الاجماع المنقول مظنون الاعتبار وظاهر الكتاب مقطوع الاعتبار.
ومنها: أن الاية لا تشمل الاخبار مع الواسطة لانصراف النبأ إلى الخبر بلا واسطة، فلا يعم الروايات المأثورة عن الائمة، عليهم السلام، لاشتمالها على وسائط.
وضعف هذا الايراد على ظاهره واضح، لان كل واسطة من الوسائط إنما يخبر خبرا بلا واسطة، فإن الشيخ، قدس سره، إذا قال: (حدثني المفيد، قال: حدثني الصدوق، قال: حدثني أبي، قال: حدثني الصفار، قال: كتبت إلى العسكري، عليه السلام، بكذا)، فإن هناك أخبارا متعددة بتعدد الوسائط.
فخبر الشيخ قوله (حدثني المفيد، إلخ) وهذا خبر بلا واسطة يجب تصديقه.
فإذا حكم بصدقه وثبت شرعا أن المفيد حدث الشيخ بقوله (حدثني الصدوق)، فهذا الاخبار - أعني قول المفيد الثابت بخبر الشيخ: (حدثني الصدوق) أيضا خبر عادل وهو المفيد، فنحكم بصدقه وأن الصدوق حدثه.
فيكون كما لو سمعنا من الصدوق إخباره بقوله (حدثني أبي)، والصدوق عادل فيصدق في خبره.
فيكون كما لو سمعنا أباه يحدث بقول: (حدثني الصفار)، فنصدقه لانه عادل، فيثبت خبر الصفار أنه كتب إليه العسكري، عليه السلام.
وإذا كان الصفار عادلا وجب تصديقه والحكم بأن العسكري، عليه السلام، كتب إليه ذلك القول، كما لو شاهدنا الامام عليه السلام يكتب إليه، فيكون المكتوب حجة، فيثبت بخبر كل لاحق أخبار سابقه.
ولهذا يعتبر العدالة في جميع الطبقات، لان كل واسطة مخبر بخبر مستقل هذا.
ولكن قد يشكل الامر: بأن - الاية انما تدل على وجوب تصديق كل مخبر، ومعنى وجوب تصديقه ليس الا ترتيب الاثار الشرعية المترتبة على صدقه عليه، فاذا قال المخبر: ان زيدا عدل، فمعنى وجوب تصديقه وجوب ترتيب الاثار الشرعية المترتبة على عدالة زيد من جواز الاقتداء به وقبول شهادته، واذا قال المخبر: أخبرني عمرو أن زيدا عادل، فمعنى تصديق المخبر على ما عرفت وجوب ترتيب الاثار الشرعية المترتبة على اخبار عمرو بعدالة زيد، ومن الاثار الشرعية المترتبة على اخبار عمرو بعدالة زيد اذا كان عادلا، وان كان هو وجوب تصديقه في عدالة زيد الا ان هذا الحكم الشرعي لاخبار عمرو انما حدث بهذه الاية، وليس من الاثار الشرعية الثابتة للمخبر به مع قطع النظر عن الاية حتى يحكم بمقتضى الاية بترتيبه على اخبار عمرو به.
والحاصل أن الاية تدل على ترتيب الاثار الشرعية الثابتة للمخبر به الواقعي على اخبار العادل، ومن المعلوم أن المراد من الاثار غير هذا الاثر الشرعي الثابت بنفس الاية، فاللازم على هذا دلالة الاية على ترتيب جميع آثار المخبر به على الخبر، الا الاثر الشرعي الثابت بهذه الاية للمخبر به اذا كان خبرا.
وبعبارة: اخرى: الاية لاتدل على وجوب قبول الخبر الذي لم يثبت موضوع الخبرية له الا بدلالة الاية على وجوب قبول الخبر، لان الحكم لايشمل الفرد الذي يصير موضوعا له بواسطة ثبوته لفرد آخر.
ومن هنا يتجه أن يقال ان أدلة قبول الشهادة لاتشمل الشهادة على الشهادة، لان الاصل لايدخل في موضوع الشاهد الا بعد قبول شهادة الفرع.
- ما يحكيه الشيخ عن المفيد صار خبرا للمفيد بحكم وجوب التصديق، فكيف يصير موضوعا لوجوب التصديق الذي لم يثبت موضوع الخبرية إلا به.
ولكن يضعف هذا الاشكال، أولا، بإنتقاضه بورود مثله في نظيره الثابت بالاجماع، كالاقرار بالاقرار، فتأمل، وإخبار العادل بعدالة مخبر، فإن الاية تشمل الاخبار بالعدالة بغير إشكال وعدم قبول الشهادة على الشهادة لو سلم ليس من هذه الجهة.
- وثانيا، بالحل: وهو أن الممتنع هو توقف فردية بعض أفراد العام على اثبات الحكم لبعضها الاخر، كما في قول القائل: كل خبري صادق أو كاذب، أما توقف العلم ببعض الافراد وانكشاف فرديته على ثبوت الحكم لبعضها الاخر كما فيما نحن فيه، فلا مانع منه.
- وثانيا، بأن عدم قابلية اللفظ العام لان يدخل فيه الموضوع الذي لا يتحقق ولا يوجد إلا بعد ثبوت حكم هذا العام لفرد آخر، لا يوجب التوقف في الحكم إذا علم المناط الملحوظ في الحكم العام وأن المتكلم لم يلاحظ موضوعا دون آخر.
فيثبت الحكم لذلك الموضوع الموجود بعد تحقق الحكم وإن لم يكن كلام المتكلم قابلا لارادة ذلك الموضوع الغير الثابت إلا بعد الحكم العام.
فاخبار عمرو بعدالة زيد فيما لو قال المخبر: أخبرني عمرو بأن زيدا عادل، وإن لم يكن داخلا في موضوع ذلك الحكم العام وإلا لزم تأخر الموضوع عن الحكم الا أنه معلوم أن هذا الخروج مستند ألى قصور العبارة وعدم قابليتها لشموله، لا للفرق بينه وبين غيره في نظر المتكلم حتى يتأمل في شمول حكم العام له، بل لا قصور في العبارة بعد ما فهم منها أن هذا المحمول وصف لازم لطبيعة الموضوع ولا ينفك عن مصاديقه.
فهو مثل ما لو أخبر زيد بعض عبيد المولى بأنه قال: لا تعمل باخبار زيد، فإنه لا يجوز أن يعمل به ولو إتكالا على دليل عام يدل على الجواز ويقول إن هذا العام لا يشمل نفسه، لان عدم شموله له ليس إلا لقصور اللفظ وعدم قابليته للشمول، لا لتفاوت بينه وبين غيره من إخبار زيد في نظر المولى.
وقد تقدم في الايراد الثاني من هذه الايرادات ما يوضح لك، فراجع.
ومنها: أن العمل بالمفهوم في الاحكام الشرعية غير ممكن، لوجوب التفحص عن المعارض لخبر العدل في الاحكام الشرعية، فيجب تنزيل الاية على الاخبار في الموضوعات الخارجية، فإنها هي التي لا يجب التفحص فيها عن المعارض، ويجعل المراد من القبول فيها هو القبول في الجملة، فلا ينافي إعتبار إنضمام عدل آخر إليه.
فلا يقال: إن قبول خبر الواحد في الموضوعات الخارجية مطلقا يستلزم قبوله في الاحكام بالاجماع المركب والاولوية.
وفيه: أن وجوب التفحص عن المعارض غير وجوب التبين في الخبر، فإن الاول يؤكد حجية خبر العادل ولا ينافيها، لان مرجع التفحص عن المعارض إلى الفحص عما أوجب الشارع العمل به، كما أوجب العمل بهذا.
والتبين المنافي للحجية هو التوقف عن العمل وإلتماس دليل آخر، فيكون ذلك الدليل هو المتبع ولو كان أصلا من الاصول.فإذا يئس عن المعارض عمل بهذا الخبر، وإذا وجده أخذ بالارجح منهما.وإذا يئس عن التبين توقف عن العمل ورجع إلى ما يقتضيه الاصول العملية.
فخبر الفاسق وإن إشترك مع خبر العادل في عدم جواز العمل بمجرد المجئ إلا أنه بعد اليأس عن وجود المنافي يعمل بالثاني دون الاول.
ومع وجدان المنافي يوخذ به في الاول ويؤخذ بالارجح في الثاني، فتتبع الادلة في الاول لتحصيل المقتضي الشرعي للحكم الي تضمنه خبر الفاسق، وفي الثاني لطلب المانع عما اقتضاه الدليل الموجود.
ومنها: أن مفهوم الاية غير معلول به في الموضوعات الخارجية التي منها مورد الاية، وهو إخبار الوليد بإرتداد طائفة.
ومن المعلوم أنه لا يكفي فيه خبر العادل الواحد، بل لا أقل من إعتبار العدلين، فلا بد من طرح المفهوم، لعدم جواز إخراج المورد.
وفيه: أن غاية الامر لزوم تقيد المفهوم بالنسبة إلى الموضوعات بما إذا تعدد المخبر العادل.
فكل واحد من خبري العدلين في البينة لا يجب التبين فيه.
وأما لزوم إخراج المورد فممنوع، لان المورد داخل في منطوق الاية لا مفهومها، وجعل أصل خبر الارتداد موردا للحكم بوجوب التبين إذا كان المخبر به فاسقا، ولعدمه إذا كان المخبر به عادلا، لا يلزم منه إلا تقييد الحكم في طرف المفهوم و إخراج بعض أفراده، وهذا ليس من إخراج المورد المستهجن في شئ.
ومنها: ما عن غاية البادي، من أن المفهوم يدل على عدم وجوب التبين، وهو لا يستلزم العمل، لجواز وجوب التوقف.
وكأن هذا الايراد مبني على ما تقدم فساده من إرادة وجوب التبين نفسيا، وقد عرفت ضعفه، وأن المراد وجوب التبين لاجل العمل عند إرادته وليس التوقف حينئذ واسطة.
ومنها: أن المسألة أصولية، فلا يكتفى فيها بالظن.
وفيه: أن الظهور اللفظي لا بأس بالتمسك به في أصول الفقه، والاصول التي لا يتمسك لها بالظن مطلقا هو أصول الدين لا أصول الفقه، والظن الذي لا يتمسك به في الاصول مطلقا هو مطلق الظن، لا الظن الخاص.
ومنها: أن المراد بالفاسق مطلق الخارج عن طاعه الله ولو بالصغائر.
فكل من كان كذلك أو احتمل في حقه ذلك وجب التبين في خبره وغيره ممن يفيد قوله العلم، لانحصاره في المعصوم ومن هو دونه.
فيكون في تعليق الحكم بالفسق إشارة إلى أن مطلق خبر المخبر غير المعصوم لا عبرة به، لاحتمال فسقه، لان المراد الفاسق الواقعي لا المعلوم.
فهذا وجه آخر لافادة الاية حرمة إتباع غير العلم، لا يحتاج معه إلى التمسك في ذلك بتعليل الاية، كما تقدم في الايراد الثاني من الايرادين الاولين.
وفيه: أن إرادة مطلق الخارج عن طاعة الله من إطلاق الفاسق خلاف الظاهر عرفا، فالمراد به إما الكافر، كما هو الشائع إطلاقه في الكتاب، حيث أنه يطلق غالبا في مقابل المؤمن.
وإما الخارج
عن طاعة الله بالمعاصي الكبيرة الثابتة تحريمها في زمان نزول هذه الاية.
فالمرتكب للصغيرة غير داخل تحت إطلاق الفاسق في عرفنا المطابق للعرف السابق، مضافا إلى قوله تعالى: (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم).
مع أنه يمكن فرض الخلو عن الصغيرة والكبيرة.كما إذا علم منه التوبة من الذنب السابق.
وبه يندفع الايراد المذكور، حتى على مذهب من يجعل كل ذنب كبيرة.
وأما إحتمال فسقه بهذا الخبر لكذبه فيه فهو غير قادح، لان ظاهر قوله: (إن جاءكم فاسق بنبأ)، تحقق الفسق قبل النبأ، لا به، فالمفهوم يدل على قبول خبر من ليس فاسقا مع قطع النظر عن هذا النبأ واحتمال فسقه به.
هذه جملة مما أوردوه على ظاهر الاية، وقد عرفت أن الوارد منها إيرادان، والعمدة الايراد الاول الذي أورده جماعة من القدماء والمتأخرين.
ثم إنه استدل بمفهوم الاية على حجية خبر العادل، كذلك قد يستدل بمنطوقها على حجية خبر غير العادل إذا حصل الظن بصدقه، بناء على أن المراد بالتبين ما يعم تحصيل الظن.
فإذا حصل من الخارج ظن بصدق خبر الفاسق كفى في العمل به.
ومن التبين الظني تحصيل شهرة العلماء على العمل بالخبر او على مضمونه أو على روايته.
ومن هنا تمسك بعض بمنطوق الاية على حجية الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة.
وفي حكم الشهرة أمارة أخرى غير معتبرة.
ولو عمم التبين للتبين الاجمالي - وهو تحصيل الظن بصدق مخبره - دخل خبر الفاسق المتحرز عن الكذب، فيدخل الموثق وشبهه بل الحسن أيضا.
وعلى ما ذكر فيثبت من آية النبا، منطوقا ومفهوما، حجية الاقسام الاربعة للخبر الصحيح والحسن والموثق والضعيف المحفوف بقرينة ظنية.ولكن فيه من الاشكال ما لا يخفى، لان التبين ظاهر في العلمي.
كيف ولو كان المراد مجرد الظن لكان الامر به في خبر الفاسق لغوا، إذ العاقل لا يعمل بخبر إلا بعد رجحان صدقه على كذبه، إلا أن يدفع اللغوية بما ذكرنا سابقا، من أن المقصود التنبيه والارشاد على أن الفاسق لا ينبغي أن
يعتمد عليه وأنه لا يؤمن من كذبه وإن كان المظنون صدقه.
وكيف كان، فمادة التبين ولفظ الجهالة وظاهر التعليل كلها آبية من إرادة مجرد الظن.
نعم يمكن دعوى صدقه على الاطمينان الخارج عن التحير والتزلزل بحيث لا يعد في العرف العمل به تعريضا للوقوع في الندم.فحينئذ لا يبعد إنجبار خبر الفاسق به.
لكن لو قلنا بظهور المنطوق في ذلك كان دالا على حجية الظن الاطميناني المذكور وإن لم يكن معه خبر فاسق نظرا إلى أن الظاهر من الاية أن خبر الفاسق وجوده كعدمه، وأنه لا بد من تبين الامر من الخارج والعمل على ما يقتضيه التبين الخارجي.
نعم ربما يكون نفس الخبر من الامارات التي يحصل من مجموعها التبين.
فالمقصود الحذر عن الوقوع في مخالفة الواقع.
فكلما حصل الامن منه جاز العمل، فلا فرق حينئذ بين خبر الفاسق المعتضد بالشهرة إذا حصل الاطمينان بصدقه وبين الشهرة المجردة إذا حصل الاطمينان بصدق مضمونها.
والحاصل: أن الاية تدل على أن العمل يعتبر فيه التبين من دون مدخلية لوجود خبر الفاسق و عدمه، سواء قلنا بأن المراد منه العلم أو الاطمينان أو مطلق الظن.
حتى أن من قال بأن خبر الفاسق يكفي فيه مجرد الظن بمضمونه بحسن أو توثيق أو غيرهما من صفات الراوي، فلازمه القول بدلالة الاية على حجية مطلق الظن بالحكم الشرعي وإن لم يكن معه خبر أصلا، فافهم واغتنم واستقم، هذا.
ولكن لا يخفى أن حمل التبين على تحصيل مطلق الظن أو الاطمينان يوجب خروج مورد المنطوق وهو الاخبار بالارتداد.
ومن جملة الايات: قوله تعالى في سورة البراءة: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون).
دلت على وجوب الحذر عند إنذار المنذرين من دون إعتبار إفادة خبرهم العلم لتواتر أو قرينة، فيثبت وجوب العمل بخبر الواحد.أما وجوب الحذر، فمن وجهين.
أحدهما: أن لفظة (لعل) بعد إنسلاخها عن معنى الترجي ظاهرة في كون مدخولها محبوبا للمتكلم.
وإذا تحقق حسن الحذر ثبت وجوبه، إما لما ذكره في المعالم، من أنه لا معنى لندب الحذر، إذ مع قيام المقتضي يجب ومع عدمه لا يحسن، وإما لان رجحان العمل بخبر الواحد مستلزم لوجوبه بالاجماع المركب، لان كل من أجازه فقد أوجبه.
الثاني: أن ظاهر الاية وجوب الانذار، لوقوعه غاية للنفر الواجب بمقتضى كلمة (لولا)، فإذا وجب الانذار أفاد وجوب الحذر لوجهين.
أحدهما وقوعه غاية للواجب، فإن الغاية المترتبة على فعل الواجب مما لا يرضى الآمر بإنتفائه، سواء كان من الافعال المتعلقة للتكليف أم لا، كما في قولك: (تب لعلك تفلح، وأسلم لعلك تدخل الجنة)، وقوله تعالى: (فقولا قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى).
الثاني أنه إذا وجب الانذار ثبت وجوب القبول وإلا لغى الانذار.
ونظير ذلك ما تمسك به في المسالك على وجوب قبول قول المرأة وتصديقها في العدة، من قوله تعالى: (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن)، فاستدل بتحريم الكتمان ووجوب الاظهار عليهن على قبول قولهن بالنسبة إلى ما في الارحام.
فإن قلت: المراد بالنفر النفر إلى الجهاد، كما يظهر من صدر الاية، وهو قوله تعالى: (وما كان المؤمنون لينفروا كافة)، ومن المعلوم أن النفر إلى الجهاد ليس للتفقه والانذار، نعم ربما يترتبان عليه، بناء على ما قيل، من أن المراد حصول البصيرة في الدين من مشاهدة آيات الله وظهور أوليائه على أعدائه وسائل ما يتفق في حرب المسلمين مع الكفار من آيات عظمة الله وحكمته، فيخبروا بذلك عند رجوعهم إلى الفرقة المتخلفة الباقية في المدينة.
فالتفقه والانذار من قبيل الفائدة لا الغاية حتى تجب بوجوب ذيها.
قلت: أولا، إنه ليس في صدر الاية دلالة على أن المراد النفر إلى الجهاد، وذكر الاية في آيات الجهاد لا يدل على ذلك.
وثانيا، لو سلم أن المراد النفر إلى الجهاد، لكن لا يتعين أن يكون النفر من كل قوم طائفة لاجل مجرد الجهاد، بل لو كان لمحض الجهاد لم يتعين أن ينفر من كل قوم طائفة، فيمكن أن يكون التفقه غاية لايجاب النفر على كل طائفة من كل قوم، لا لايجاب أصل النفر.
وثالثا، إنه فسر الاية بأن المراد نهي المؤمنين عن نفر جميعهم إلى الجهاد، كما يظهر من قوله: (وما كان المؤمنون لينفروا كافة)، وأمر بعضهم بأن يتخلفوا عند النبي، صلى الله عليه وآله، ولا يخلوه وحده، فيتعلموا مسائل حلالهم وحرامهم حتى ينذروا قومهم النافرين إذا رجعوا إليهم.
والحاصل: أن ظهور الاية في وجوب التفقه والانذار مما لا ينكر، فلا محيص عن حمل الاية عليه وإن لزم مخالفة الظاهر في سياق الاية أو بعض ألفاظها.
* * *
ومما يدل على ظهور الاية في وجوب التفقه والانذار إستشهاد الامام بها على وجوبه في أخبار كثيرة.
منها: ما عن الفضل بن شاذان في علله عن الرضا، عليه السلام، في حديث، قال: (إنما أمروا بالحج لعلة الوفادة إلى الله وطلب الزيادة والخروج عن كل ما اقترف العبد - إلى أن قال: - ولاجل ما فيه من التفقه ونقل اخبار الائمة، عليهم السلام، إلى كل صفح وناحية.
كما قال الله عزوجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، الاية).
ومنها: ما ذكره في ديباجة المعالم، من رواية علي بن حمزة، قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: تفقهوا في الدين، فإن من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي، إن الله عزوجل يقول: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون).
ومنها: ما رواه في الكافي، في باب ما يجب على الناس عند مضي.
الامام، عليه السلام، عن صحيحة يعقوب بن شعيب: (قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إذا حدث على الامام حدث كيف يصنع الناس؟ قال: أين قول الله عزوجل: (فلولا نفر..اه).
قال: هم في عذر ما داموا في الطلب، وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر حتى يرجع إليهم أصحابهم).
ومنها: صحيحة عبدالاعلى قال: (سألت أبا عبدالله، عليه السلام، عن قول العامة إن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية.
قال: حق والله.
قلت: فإن إماما هلك، ورجل في خراسان لا يعلم من وصيه، لم يسعه ذلك؟ قال: لا يسعه إن الامام إذا مات وقعت حجة على من هو معه في البلد، وحق النفر على من ليس بحضرته إذا بلغهم أن الله عزوجل يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، اه).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام.
وفيها: (قلت: أفيسع الناس إذا مات العالم أن لا يعرفوا الذي بعده؟ فقال: أما أهل هذه البلدة فلا - يعني أهل المدينة - وأما غيرها من البلدان فبقدر مسيرهم، إن الله عزوجل يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة).
ومنها: صحيحة البزنطي المروية في قرب الاسناد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام.
ومنها: رواية عبدالمؤمن الانصاري الواردة في جواب من سأل عن قوله صلى الله عليه وآله: (إختلاف أمتي رحمة.
قال: إذا كان إختلافهم رحمة فإتفاقهم عذاب ! ليس هذا يراد، إنما يراد الاختلاف في طلب العلم، على ما قال الله عزوجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة)، الحديث منقول بالمعنى، ولا يحضرني ألفاظه.
وجميع هذا هو السر في إستدلال أصحابنا بالاية الشريفة على وجوب تحصيل العلم وكونه كفائيا.
هذا غاية ما قيل أو يقال في توجيه الاستدلال بالاية الشريفة.
* * *
لكن الانصاف: عدم جواز الاستدلال بها من وجوه:
الاول: أنه لا يستفاد من الكلام إلا مطلوبية الحذر عقيب الانذار بما يتفقهون في الجملة، لكن ليس فيها إطلاق وجوب الحذر، بل يمكن أن يتوقف وجوبه على حصول العلم، فالمعنى: لعله يحصل لهم العلم فيحذروا.
فالاية مسوقة لبيان مطلوبية الانذار بما يتفقهون ومطلوبية العمل من المنذرين بما أنذروا.
وهذا لا ينافي إعتبار العلم في العمل.
ولهذا صح ذلك فيما يطلب فيه العلم.
فليس في هذه الاية تخصيص للادلة الناهية عن العمل بما لم يعلم.
ولذا إستشهد الامام، فيما سمعت من الاخبار المتقدمة، على وجوب النفر في معرفة الامام، عليه السلام، وإنذار النافرين للمتخلفين، مع أن الامامة لا تثبت إلا بالعلم.
الثاني: أن التفقه الواجب ليس إلا معرفة الامور الواقعية من الدين، فالانذار الواجب هو الانذار بهذه الامور المتفقه فيها.فالحذر لا يجب إلا عقيب الانذار بها.فإذا لم يعرف المنذر - بالفتح - أن الانذار هل وقع بالامور الدينية الواقعية أو بغيرها خطاء أو تعمدا من المنذر - بالكسر - لم يجب الحذر حينئذ.
فانحصر وجوب الحذر فيما إذا علم المنذر صدق المنذر في إنذاره بالاحكام الواقعية.فهو نظير
قول القائل: أخبر فلانا بأوامري، لعله يمتثلها.
فهذه الاية نظير ما ورد من الامر بنقل الروايات، فإن المقصود من هذا الكلام ليس إلا وجوب العمل بالامور الواقعية، لا وجوب تصديقه فيما يحكي ولو لم يعلم مطابقته للواقع.
ولا يعد هذا ضابطا لوجوب العمل بالخبر الظني الصادر من المخاطب في الامر الكذائي.
ونظيره جميع ما ورد من بيان الحق للناس ووجوب تبليغه إليهم، فإن المقصود منه إهتداء الناس إلى الحق الواقعي، لا إنشاء حكم ظاهري لهم بقبول كل ما يخبرون به وإن لم يعلم مطابقته للواقع.
ثم الفرق بين هذا الايراد وسابقه: أن هذا الايراد مبني على أن الاية ناطقة بإختصاص مقصود المتكلم بالحذر عن الامور الواقعية المستلزم لعدم وجوبه إلا بعد إحراز كون الانذار متعلقا بالحكم الواقعي.
وأما الايراد السابق فهو مبني على سكوت الاية عن التعرض لكون الحذر واجبا على الاطلاق أو بشرط حصول العلم.
الثالث: لو سلمنا دلالة الاية على وجوب الحذر مطلقا عند إنذار المنذر ولو لم يفد العلم، لكن لا تدل على وجوب العمل بالخبر من حيث أنه خبر، لان الانذار هو الابلاغ مع التخويف.
فإنشاء التخويف مأخوذ فيه، والحذر هو التخوف الحاصل عقيب هذا التخويف الداعي إلى العمل بمقتضاه فعلا، ومن المعلوم أن التخويف لا يجب إلا على الوعاظ في مقام الايعاد على الامور التي يعلم المخاطبون بحكمها من الوجوب والحرمة، كما يوعد على شرب الخمر وفعل الزنا وترك الصلاة، أو على المرشدين في مقام إرشاد الجهال.
فالتخوف لا يجب إلا على المتعظ والمسترشد.
ومن المعلوم أن تصديق الحاكي فيما يحكيه من لفظ الخبر الذي هو محل الكلام خارج عن الامرين.
توضيح ذلك أن المنذر إما أن ينذر ويخوف على وجه الافتاء ونقل ما هو مدلول الخبر بإجتهاده، وإما أن ينذر ويخوف بلفظ الخبر حاكيا له عن الحجة.
فالاول: كأن يقول: يا أيها الناس ! إتقوا الله في شرب العصير، فإن شربه يوجب المؤاخذة.
والثاني: كأن يقول: في مقام التخويف قال الامام عليه السلام: من شرب العصير فكأنما شرب الخمر.
أما الانذار على الوجه الاول، فلا يجب الحذر عقيبه إلا على المقلدين لهذا المفتي.
وأما الثاني، فله جهتان: إحداهما جهة تخويف وإيعاد، والثانية جهة حكاية قول الامام عليه السلام.
ومن المعلوم أن الجهة الاولى ترجع إلى الاجتهاد في معنى الحكاية، فهي ليست حجة إلا على من هو مقلد له، إذ هو الذي يجب عليه التخوف عند تخويفه.
وأما الجهة الثانية فهي التي تنفع المجتهد الآخر الذي يسمع منه هذه الحكاية، لكن وظيفته مجرد تصديقه في صدور هذا الكلم عن الامام عليه السلام.
وأما أن مدلوله متضمن لما يوجب التحريم الموجب للخوف أو الكراهة، فهو ما ليس فهم المنذر حجة فيه بالنسبة إلى هذا المجتهد.
فالاية الدالة على وجوب التخوف عند تخويف المنذرين مختصة بمن يجب عليه اتباع المنذر في مضمون الحكاية وهو المقلد له، للاجماع على أنه لا يجب على المجتهد التخوف عند إنذار غيره.
إنما الكلام في أنه هل يجب عليه تصديق غيره في الالفاظ الاصوات التي يحكيها عن المعصوم عليه السلام أم لا، والاية لا تدل على وجوب ذلك على من لا يجب عليه التخوف عند التخويف.
فالحق: أن الاستدلال بالاية على وجوب الاجتهاد كفاية ووجوب التقليد على العوام أولى من الاستدلال بها على وجوب العمل بالخبر.
وذكر شيخنا البهائي، قدس سره، في أول أربعينه: (أن الاستدلال بالنبوي المشهور: (من حفظ على أمتي أربعين حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما)، على حجية الخبر لا يقصر عن الاستدلال عليها بهذه الاية).
وكان فيه إشارة إلى ضعف الاستدلال بها، لان الاستدلال بالحديث المذكور ضعيف جدا، كما سيجئ إن شاء الله عند ذكر الاخبار.
ولكن ظاهر الرواية المتقدمة عن علل الفضل يدفع هذا الايراد، لكنها من الآحاد، فلا ينفع في صرف الايه من ظاهرها في مسألة حجية الآحاد مع إمكان منع دلالتها على المدعى، لان الغالب تعدد من يخرج إلى الحج من كل صقع، بحيث يكون الغالب حصول القطع من حكايتهم لحكمالله الواقعي، عن الامام، عليه السلام، وحينئذ فيجب الحذر عقيب إنذارهم.فإطلاق الرواية منزل على الغالب).
ومن جملة الايات التي استدل بها جماعة، تبعا للشيخ في العدة على حجية الخبر، قوله تعالى: (إن الذين يكتموت ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون)، الاية.
والتقريب فيه: نظير ما بيناه في آية النفر، من أن حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول عند الاظهار.
ويرد عليها: ما ذكرنا من الايرادين الاولين في آية النفر، من سكوتها وعدم التعرض فيها لوجوب القبول وإن لم يحصل العلم عقيب الاظهار أو إختصاص وجوب القبول المستفاد منها بالامر الذي يحرم كتمانه ويجب إظهاره، فإن من أمر غيره بإظهار الحق للناس ليس مقصوده إلا عمل الناس بالحق، ولا يريد بمثل هذا الخطاب تأسيس حجية قول المظهر تعبدا ووجوب العمل بقوله و إن لم يطابق الحق.
ويشهد لما ذكرنا: أن مورد الاية كتمان اليهود لعلامات النبي، صلى الله عليه وآله، بعد ما بين الله لهم ذلك في التوراة، ومعلوم أن آيات النبوة لا يكتفى فيها بالظن.
نعم لو وجب الاظهار على من لا يفيد قوله العلم غالبا أمكن جعل ذلك دليلا على أن المقصود العمل بقوله وإن لم يفد العلم، لئلا يكون إلقاء هذا الكلام كاللغو.
ومن هنا يمكن الاستدلال بما تقدم - من آية تحريم كتمان ما في الارحام على النساء - على وجوب تصديقهن، وبآية وجوب إقامة الشهادة على وجوب قبولها بعد الاقامة، مع إمكان كون وجوب الاظهار لاجل رجاء وضوح الحق من تعدد المظهرين.
ومن جملة الآيات التي استدل بها بعض المعاصرين قوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون).
بناء على أن وجوب السؤال يستلزم وجوب قبول الجواب وإلا لغى وجوب السؤال.
وإذا وجب قبول الجواب وجب قبول كل ما يصح أن يسأل عنه ويقع جوابا له، لان خصوصية المسبوقية بالسؤال لا دخل فيه قطعا.
فإذا سئل الراوي الذي هو من أهل العلم عما سمعه عن الامام، عليه السلام، في خصوص الواقعة، فأجاب باني سمعته يقول كذا، وجب القبول، بحكم الاية.
فيجب قبول قوله إبتداء: (إنى سمعت الامام عليه السلام يقول كذا)، لان حجية قوله هو الذي أوجب السؤال عنه، لا أن وجوب السؤال أوجب قبول قوله، كما لا يخفى.
ويرد عليه: أن الاستدلال إن كان بظاهر الاية، فظاهرها بمقتضى السياق إرادة علماء أهل الكتاب، كما عن إبن عباس، ومجاهد، والحسن، وقتادة.
فإن المذكور في سورة النحل: (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر)، وفي سورة الانبياء: (وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا
تعلمون).وإن كان مع قطع النظر عن سياقها.
ففيه: أولا، أنه ورد في الاخبار المتسفيضة أن أهل الذكر هم الائمة، عليه السلم.
وقد عقد في أصول الكافي بابا لذلك، وقد أرسله في المجمع عن علي عليه السلام.
ورد بعض مشايخنا هذه الاخبار بضعف السند، بناء على إشتراك بعض الروات في بعضها و ضعف بعضها في الباقي.وفيه نظر، لان روايتين منها صحيحتان، وهما روايتا محمد بن مسلم والوشاء، فلاحظ.و رواية أبي بكر الحضرمي حسنة أو موثقة.نعم ثلاث روايات أخر منها لا تخلو من ضعف ولا تقدح قطعا.
وثانيا: أن الظاهر من وجوب السؤال عند عدم العلم وجوب تحصيل العلم، لا وجوب السؤال للعمل بالجواب تعبدا، كما يقال في العرف: سل إن كنت جاهلا.
ويؤيده أن الاية واردة في أصول الدين وعلامات النبي، صلى الله عليه وآله، التي لا يؤخذ فيها بالتعبد إجماعا.
وثالثا: لو سلم حمله على إرادة وجوب السؤال للتعبد بالجواب، لا لحصول العلم منه، قلنا: إن المراد من أهل العلم ليس مطلق من علم ولو بسماع رواية من الامام، عليه السلام، وإلا لدل على حجية قول كل عالم بشئ ولو من طريق السمع والبصر، مع أنه يصح سلب هذا العنوان من مطلق من أحس شيئا بسمعه أو بصره.
والمتبادر من وجوب سؤال أهل العلم بناء على إرادة التعبد بجوابهم هو سؤالهم عما هم عالمون به ويعدون من أهل العلم في مثله.
فينحصر مدلول الاية في التقليد، ولذا تمسك به جماعة على وجوب التقليد على العامي.
وبما ذكرنا يندفع ما يتوهم من (أنا نفرض الراوي من أهل العلم.
فإذا وجب قبول روايته وجب قبول رواية من ليس من أهل العلم بالاجماع المركب).
حاصل وجه الاندفاع: أن سؤال أهل العلم عن الالفاظ التي سمعها من الامام، عليه السلام، والتعبد بقوله فيها ليس سؤالا من أهل العلم من حيث هم أهل العلم.
ألا ترى أنه لو قال: سل الفقهاء إذا لم تعلم، أو الاطباء، لا يحتمل أن يكون قد أراد ما يشمل المسموعات والمبصرات الخارجية من قيام زيد، وتكلم عمرو، وغير ذلك.
ومن جملة الايات، قوله تعالى في سورة البرائة: (ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن.
قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين).
مدح الله - عزوجل - رسوله، صلى الله عليه وآله، بتصديقه للمؤمنين، بل قرنه بالتصديق بالله جل ذكره.
فإذا كان التصديق حسنا يكون واجبا.
ويزيد في تقريب الاستدلال وضوحا ما رواه في فروع الكافي، في الحسن بابراهيم بن هاشم، أنه كان لاسماعيل بن أبي عبدالله دنانير، وأراد رجل من قريش أن يخرج بها إلى اليمن.
فقال له أبو عبدالله عليه السلام: (يا بني ! أما بلغك أنه يشرب الخمر؟ قال: سمعت الناس يقولون.
فقال: يا بني ! إن الله - عزوجل - يقول: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين.
يقول: يصدق الله ويصدق للمؤمنين.فإذا شهد عندك السملمون فصدقهم).
ويرد عليه: أولا، أن المراد بالاذن سريع التصديق والاعتقاد بكل ما يسمع، لا من يعمل تعبدا بما يسمع من دون حصول الاعتقاد بصدقه.فمدحه، عليه السلام، بذلك، لحسن ظنه بالمؤمنين وعدم إتهامهم.
وثانيا: أن المراد من التصديق في الاية ليس جعل المخبر به واقعا وترتيب جميع آثاره عليه، إذ لو كان المراد به ذلك لم يكن أذن خير لجميع الناس.
إذ لو أخبره أحد بزنا أحد أو شربه أو قذفه أو إرتداده، فقلته النبي أو جلده، لم يكن في سماعه ذلك الخبر خير للمخبر عنه، بل كان محض الشر له، خصوصا مع عدم صدور الفعل منه في الواقع.
نعم يكون خيرا للمخبر من حيث متابعة قوله وإن كان منافقا موذيا للنبي، صلى الله عليه وآله، على ما يقتضيه الخطاب في (لكم).
فثبوت الخبر لكل من المخبر والمخبر عنه لا يكون إلا إذا صدق المخبر بمعنى إظهار القبول عنه وعدم تكذيبه وطرح قوله رأسا مع العمل في نفسه بما يقتضيه الاحتياط التام بالنسبة إلى المخبر عنه.
فإن كان المخبر به مما يتعلق بسوء حاله لا يؤذيه في الظاهر، لكن يكون على حذر منه في الباطن، كما كان هو مقتضى المصلحة في حكاية إسماعيل المتقدمة.
ويؤيد هذا المعنى: ما عن تفسير العياشي عن الصادق، عليه السلام، من أنه يصدق المؤمنين،
لانه صلى الله عليه وآله كان رؤوفا رحيما بالمؤمنين.
فإن تعليل التصديق بالرأفة والرحمة على كافة المؤمنين ينافي إرادة قبول قول أحدهم على الاخر بحيث يرتب عليه آثاره وإن أنكر المخبر عنه وقوعه، إذ مع الانكار لا بد عن تكذيب أحدهما، وهو منماف لكونه أذن خير ورؤوفا رحيما لجميع المؤمنين.فتعين إرادة التصديق بالمعنى الذي ذكرنا.
ويؤيد أيضا: ما عن القمي، رحمه الله، في سبب نزول الاية: (أنه نم منافق على النبي، صلى الله عليه وآله، فأخبره الله ذلك، فأحضره النبي " ص " وسأله، فحلف: أنه لم يكن شئ مما ينم عليه، فقبل منه النبي " ص ".
فأخذ هذا الرجل بعد ذلك يطعن على النبي " ص " ويقول: إنه يقبل كل ما يسمع.
أخبره الله إني أنم عليه وأنقل أخباره، فقبل.فأخبرته أني لم أفعل، فقبل.
فرده الله - تعالى - بقوله لنبيه " ص ": (قل أذن خير لكم).
ومن المعلوم: أن تصديقه، صلى الله عليه وآله، للمنافق لم يكن بترتيب آثار الصدق عليه مطلقا.
وهذا التفسير صريح في أن المراد من المؤمنين المقرون بالايمان من غير إعتقاد، فيكون الايمان لهم على حسب إيمانهم، ويشهد بتغاير معنى الايمان في الموضعين، مضافا إلى تكرار لفظه، تعديته في الاول بالباء وفي الثاني باللام، فافهم.
وأما توجيه الرواية فيحتاج إلى بيان معنى التصديق، فنقول: إن المسلم إذا أخبر بشئ فلتصديقه معنيان.
أحدهما: ما يقتضيه أدلة تنزيل فعل المسلم على الصحيح والاحسن، فإن الاخبار، من حيث أنه فعل من أفعال المكلفين، صحيحه ما كان مباحا وفاسده ما كان نقيضه، كالكذب والغيبة ونحوهما، فحمل الاخبار على الصادق حمل على أحسنه.
والثاني: هو حمل إخباره، من حيث أنه لفظ دال على معنى يحتمل مطابقته للواقع وعدمها، على كونه مطابقا للواقع بترتيب آثار الواقع عليه.
والحاصل أن المعنى الثاني هو الذي يراد من العمل بخبر العادل.
وأما المعنى الاول، فهو الذي يقتضيه أدلة حمل فعل المسلم على الصحيح والاحسن.
وهو ظاهر الاخبار الواردة في: أن من حق المؤمن على المؤمن أن يصدقه ولا يتهمه، خصوصا مثل قوله عليه السلام:
(يا أبا محمد ! كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك خمسون قسامة أنه قال قولا، وقال: لم أقله، فصدقه وكذبهم، الخبر).
فإن تكذيب القسامة، مع كونهم أيضا مؤمنين، لا يراد منه إلا عدم ترتيب آثار الواقع على كلامهم.
لا ما يقابل تصديق المشهود عليه، فإنه ترجيح بلا مرجح، بل ترجيح المرجوح.
نعم خرج من ذلك مواضع وجوب قبول شهادة المؤمن على المؤمن وإن أنكر المشهود عليه.
وأنت إذا تأملت هذه الرواية ولاحظتها مع الرواية المتقدمة في حكاية إسماعيل، لم يكن لك بد من حمل التصديق على ما ذكرنا.
وإن أبيت إلا عن ظهور خبر إسماعيل في وجوب التصديق بمعنى ترتيب آثار الواقع، فنقول: إن الاستعانة بها على دلالة الاية خروج عن الاستدلال بالكتاب إلى السنة، والمقصود هو الاول.
غاية الامر كون هذه الرواية في عداد الروايات الاتية إن شاء الله تعالى.
ثم إن هذه الايات على تقدير تسليم دلالة كل واحد منها على حجية الخبر إنما تدل، بعد تقييد المطلق منها الشامل لخبر العادل وغيره بمنطوق آية النبأ، على حجية خبر العادل الواقعي أو من أخبر عدل واقعي بعدالته.
بل يمكن إنصراف المفهوم بحكم الغلبة إلى صورة إفادة خبر العادل الظن الاطميناني بالصدق، كما هو الغالب مع القطع بالعدالة.
فيصير حاصل مدلول الايات إعتبار خبر العادل الواقعي بشرط إفادته الظن الاطميناني والوثوق، بل هذا أيضا منصرف سائر الآيات وإن لم يكن إنصرافا موجبا لظهور عدم إرادة غيره، حتى يعارض المنطوق.
وأما السنة فطوائف من الاخبار منها: ما ورد في الخبرين المتعارضين من الاخذ بالاعدل والاصدق والمشهور والتخيير عند التساوي.
مثل مقبولة عمر بن حنظلة، حيث يقول: (الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث).
وموردها وإن كان في الحاكمين إلا أن ملاحظة جميع الرواية تشهد بأن المراد بيان المرجح للروايتين اللتين إستند إليهما الحاكمان.
ومثل رواية عوالي اللئالي المروية عن العلامة المرفوعة إلى زرارة: (قال: يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان، فبأيهما نأخذ؟ قال: خذ بما إشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر.
قلت: فإنهما معا مشهوران، قال: خذ بأعدلهما وأوثقهما في نفسك).
ومثل رواية إبن أبي الجهم عن الرضا، عليه السلام، قلت: يجيئنا الرجلان، وكلاهما ثقة، بحديثين مختلفين، فلا نعلم أيهما الحق.
قال: إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت).
ورواية الحارث بن المغيرة عن الصادق، عليه السلام، قال: (إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة، فموسع عليك حتى ترى القائم).وغيرها من الاخبار.
والظاهر: أن دلالتها على إعتبار الخبر الغير المقطوع الصدور واضحة.
إلا أنه لا إطلاق لها، لان السؤال عن الخبرين اللذين فرض السائل كلا منهما حجة يتعين العمل بها لولا المعارض، كما يشهد به السؤال بلفظ (أي) الدالة على السؤال عن المعين مع العلم بالمبهم.
فهو كما إذا سئل عن تعارض الشهود أو أئمة الصلاة، فأجاب ببيان المرجح، فإنه لا يدل إلا على أن المفروض تعارض من كان منهم مفروض القبول لولا المعارض.
نعم رواية إبن المغيرة تدل على إعتبار خبر كل ثقة.
وبعد ملاحظة ذكر الاوثقية والاعدلية في المقبولة والمرفوعة يصير الحاصل من المجموع إعتبار خبر الثقة، بل العادل.
لكن الانصاف: أن ظاهر مساق الرواية أن الغرض من العدالة حصول الوثاقة، فيكون العبرة بها.
ومنها: ما دل على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحابهم، عليهم السلام، بحيث يظهر منه عدم الفرق بين الفتوى والرواية.
مثل إرجاعه، عليه السلام، إلى زرارة، بقوله عليه السلام: (إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس.
مشيرا إلى زرارة).
وقوله، عليه السلام، في رواية أخرى: (وأما ما رواه زرارة عن أبى، عليه السلام، فلا يجوز رده) وقوله، عليه السلام لابن أبي يعفور - بعد السؤال عمن يرجع إليه إذا إحتاج أو سئل عن مسألة: (فما يمنعك عن الثقفي؟ - يعني محمد بن مسلم - فإنه سمع من ابي أحاديث، و كاعنده وجيها).
وقولة، عليه السلام، فيما عن الكشي لسلمة بن أبي حبيبة: (إئت أبان بن تغلب، فإنه قد سمع مني حديثا كثيرا.
فما روى لك عني فاروه عني).
وقوله، عليه السلام، لشعيب العقرقوفي بعد السؤال عمن يرجع إليه: (عليك بالاسدي، يعني أبا بصير).
وقوله عليه السلام، لعلي إبن المسيب بعد السؤال عمن يأخذ عنه معالم الدين:
(عليك بزكريا إبن آدم المأمون على الدين والدنيا).
وقوله عليه السلام، لما قال له عبدالعزيز بن المهتدي: (ربما أحتاج ولست ألقاك في كل وقت، أفيونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ قال: نعم).وظاهر هذه الرواية أن قبول قول الثقة كان أمرا مفروغا عنه عند الراوي.
فسأل عن وثاقة يونس، ليترتب عليه أخذ المعالم منه.
ويؤيده في إناطة وجوب القبول بالوثاقة ما ورد في العمري وإبنه اللذين هما من النواب والسفراء.
ففي الكافي في باب النهي عن التسمية: (عن الحميرى عن أحمد بن إسحاق.
قال: سألت أبا الحسن، عليه السلام، و قلت له: من أعامل وعمن آخذ وقول من أقبل؟ فقال عليه السلام له: العمرى ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له و أطع، فإنه الثقة المأمون).
وأخبرنا أحمد بن إسحق أنه سأل أبا محمد، عليه السلام، عن مثل ذلك، فقال له: (العمري وإبنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما، فإنهما الثقتان المأمونان، الخبر).
وهذه الطائفة أيضا مشتركة مع الطائفه الاولى في الدلالة على إعتبار خبر الثقة المأمون.
ومنها: ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء على وجه يظهر منه عدم الفرق بين فتواهم بالنسبة إلى أهل الاستفتاء وروايتهم بالنسبة إلى أهل العمل بالرواية.
مثل قول الحجة - عجل الله فرجه - لاسحاق بن يعقوب، على ما في كتاب الغيبة للشيخ، وإكمال الدين، للصدوق، والاحتجاج للطبرسي: (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فانهم حجتي عليكم و أنا حجة الله عليهم).
فإنه لو سلم أن ظاهر الصدر الاختصاص بالرجوع في حكم الوقائع إلى الرواة، أعني الاستفتاء
منهم، إلا أن التعليل بأنهم حجته، عليه السلام، يدل على وجوب قبول خبرهم.
ومثل الرواية المحكية عن العدة من قوله عليه السلام: (إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا، فانظروا إلى ما رووه عن علي، عليه السلام).
دل على الاخذ بروايات الشيعة وروايات العامة مع عدم وجود المعارض من رواية الخاصة.
ومثل ما في الاحتجاج عن تفسير العسكري، عليه السلام، - في قوله تعالى: (ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب)، الاية - من أنه قال رجل للصادق عليه السلام: (فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود والنصارى لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم، لا سبيل لهم إلى غيره.
فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم؟ وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم؟ فإن لم يجز لاولئك القبول من علمائهم لم يجز لهؤلاء القبول من علمائهم).
فقال عليه السلام: (بين عوامنا وعلمائنا وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة.
أما من حيث إستووا، فإن الله - تعالى - ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم.كما ذم عوامهم بتقليدهم علماءهم.
وأما من حيث إفترقوا فلا.
قال: بين لي يابن رسول الله ! قال: إن عوام اليهود قد عرفوا علماءهم بالكذب الصريح وبأكل الحرام و الرشاء وبتغيير الاحكام عن وجهها بالشفاعات والنسابات والمصانعات، و عرفوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون به أديانهم، وأنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه، وأعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم و ظلموهم من أجلهم، وعلموهم يقارفون المحرمات واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق، لا يجوز أن يصدق على الله تعالى ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله تعالى.
فلذلك ذمهم لما قلدوا من عرفوا ومن علموا أنه لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه ولا العمل بما يؤديه إليهم عمن لم يشاهدوه ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ كانت دلائله أوضح من
أن تخفى وأشهر من أن لا تظهر لهم.
وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لاصلاح أمره مستحقا، والترفرف بالبر والاحسان على من تعصبوا له وإن كان للاذلال والاهانة مستحقا.
فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء، فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم.
فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لامر مولاه، فللعوام أن يقلدوه.
وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة، لا جميعهم.
فأما من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا، ولا كرامة.
وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك، لان الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره لجهلهم، ويضعون الاشياء على غير وجوهها لقلة معرفتهم، وآخرون يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم.
ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا، فيتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون عند شيعتنا وينتقصون بنا عند أعدائنا، ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الاكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوا.
أولئك أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد، لعنه الله، على الحسين بن علي عليه السلام)، إنتهى.
دل هذا الخبر الشريف اللائح منه آثار الصدق على جواز قبول قول من عرف بالتحرز عن الكذب وإن كان ظاهره إعتبار العدالة بل ما فوقها.
لكن المستفاد من مجموعه أن المناط في التصديق هو التحرز من الكذب، فافهم.
ومثل ما عن أبي الحسن، عليه السلام، فيما كتبه جوابا عن السؤال عمن نعتمد عليه في الدين، قال: (اعتمدا في دينكما على كل مسن في حبنا كثير القدم في أمرنا).
وقوله عليه السلام، في رواية أخرى: (لا تأخذن معالم دينك من غير شعيتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك من الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم.
إنهم ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه)، الحديث.
وظاهرهما وإن كان الفتوى، إلا أن الانصاف شمولهما للرواية بعد التأمل، كما تقدم في سابقتهما.
ومثل ما في كتاب الغيبة، بسنده الصحيح إلى عبدالله الكوفي خادم الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح، حيث سأله أصحابه عن كتب الشلمعاني.
فقال الشيخ: (أقول فيها ما قاله العسكري، عليه السلام، في كتب بني فضال، حيث قالوا له: مانصنع بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟ قال: خذوا ما رووا، وذروا ما رأو).
فإنه دل بمورده على جواز الاخذ بكتب بني فضال وبعدم الفصل على كتب غيرهم من الثقات ورواياتهم.
ولهذا إن الشيخ الجليل المذكور الذي لا يظن به القول في الدين بغير السماع من الامام عليه السلام: قال: (أقول في كتب الشلمغاني ما قاله العسكري، عليه السلام، في كتب بني فضال).مع أن هذا الكلام بظاهره قياس باطل.
ومثل ما ورد مستفيضا في المحاسن وغيره: (حديث واحد في حلال وحرام تأخذه من صادق خير لك من الدنيا وما فيها من ذهب وفضة.
وفي بعضها: يأخذ صادق عن صادق).
ومثل ما في الوسائل عن الكشي، من أنه ورد توقيع على القاسم بن العلي.
و فيه: (إنه لا عذر لاحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا قد علموا أنا نفاوضهم سرنا ونحمله إليهم).
ومثل مرفوعة الكناني عن الصادق، عليه السلام، في تفسير قوله تعالى: (و من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب).
قال: (هؤلاء قوم من شيعتنا ضعفاء، وليس عندهم ما يتحملون به إلينا فيستمعون حديثنا و يفتشون من علمنا، فيرحل قوم فوقهم وينفقون أموالهم ويتعبون أبدانهم حتى يدخلوا علينا ويسمعوا حديثنا فينقلوا إليهم فيعيه أولئك ويضيعه هؤلاء.
فأولئك
الذين يجعل الله لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون).
دل على جواز العمل بالخبر وإن نقله من يضيعه ولا يعمل به.
ومنها: الاخبار الكثيرة التي يظهر من مجموعها جواز العمل بخبر الواحد وإن كان في دلالة كل واحد على ذلك نظر.
مثل النبوي المستفيض بل المتواتر: (إنه من حفظ على أمتي أربعين حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة).
قال شيخنا البهائي، قدس سره، في أول أربعينه: (إن دلالة هذا الخبر على حجية خبر الواحد لا يقصر عن دلالة آية النفر).
ومثل الاخبار الكثيرة الواردة في الترغيب في الرواية والحث عليها وإبلاغ ما في كتب الشيعة، مثل ما ورد في شأن الكتب التي دفنوها لشدة التقية.
فقال عليه السلام: (حدثوا بها فإنها حق).ومثل ما ورد في مذاكرة الحديث والامر بكتابته.
مثل قوله للراوي: (اكتب وبث علمك في بني عمك، فإنه يأتي زمان هرج، لا يأنسون إلا بكتبهم).
وما ورد في ترخيص النقل بالمعنى.
وما ورد مستفيضا، بل متواترا، من قولهم عليهم السلام: (إعرفوا منازل الرجال منا بقدر روايتهم عنا).
وما ورد من قولهم عليهم السلام: (لكل رجل منا من يكذب عليه).
وقوله صلى الله عليه و آله: (ستكثر بعدي القالة، وإن من كذب علي فليتبوء مقعده من النار).
وقول أبي عبدالله عليه السلام: (إنا أهل بيت صديقون، لا نخلو من كذاب يكذب علينا).
وقوله عليه السلام: (إن الناس أولعوا الكذب علينا، كأن الله إفترض عليهم ولا يريد منهم غيره).
وقوله عليه السلام: (لكل منا من يكذب عليه) فإن بناء المسلمين لو كان على الاقتصار على المتواترات لم يكثر القالة، والكذابة والاحتفاف
بالقرينة القطعية في غاية القلة.
إلى غير ذلك من الاخبار التي يستفاد من مجموعها رضاء الائمة، عليهم السلام، بالعمل بالخبر وإن لم يفد القطع.
وقد إدعى في الوسائل تواتر الاخبار بالعمل بخبر الثقة، إلا أن القدر المتيقن منها هو خبر الثقة الذي يضعف فيه إحتمال الكذب على وجه لا يعتني به العقلاء ويقبحون التوقف فيه لاجل ذلك الاحتمال.
كما دلا عليه ألفاظ الثقة والمأمون والصادق وغيرها الواردة في الاخبار المتقدمة، وهي ايضا منصرف إطلاق غيرها.
وأما العدالة، فأكثر الاخبار المتقدمة خالية عنها، بل في كثير منها التصريح بخلافه، مثل رواية العقدة الآمرة بالاخذ بما رووه عن علي، عليه السلام، والواردة في كتب بني فضال، ومرفوعة الكناني، وتاليها.
نعم في غير واحد منها حصر المعتمد في أخذ معالم الدين في الشيعة، لكنه محمول على غير الثقة أو على أخذ الفتوى، جمعا بينها وبين ما هو أكثر منها.
وفي رواية بني فضال شهادة على هذا الجمع، مع أن التعليل للنهي في ذيل الرواية بأنهم ممن خانوا الله ورسوله يدل على إنتفاء النهي عند إنتفاء الخيانة المكشوف عنه بالوثاقة، فإن الغير الامامي الثقة، مثل إبن فضال وإبن بكير، ليسوا خائنين في نقل الرواية.وسيأتى توضيحه عند ذكر الاجماع إن شاء الله.
وأما الاجماع، فتقريره من وجوه أحدها الاجماع على حجية خبر الواحد في مقابل السيد وأتباعه وطريق تحصيله أحد وجهين، على سبيل منع الخلو.
أحدهما: تتبع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين، فيحصل من ذلك القطع بالاتفاق الكاشف عن رضاء الامام، عليه السلام، بالحكم أو عن وجود نص معتبر في المسألة.
ولا يعتنى بخلاف السيد وأتباعه، إما لكونهم معلومي النسب، كما ذكر الشيخ في العدة، وإما للاطلاع على أن ذلك لشبهة حصلت لهم، كما ذكره العلامة في النهاية، ويمكن أن يستفاد من العدة أيضا، وإما لعدم إعتبار إتفاق الكل في الاجماع على طريق المتأخرين المبني على الحدس.
والثاني: تتبع الاجماعات المنقولة في ذلك: فمنها: ما حكي عن الشيخ، قدس سره، في العدة في هذا المقام حيث قال: (وأما ما اخترته من المذهب، فهو أن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالامامة - وكان ذلك مرويا عن النبي، صلى الله عليه وآله، أو عن أحد الائمة، عليهم السلام، وكان ممن لا يطعن في روايته ويكون سديدا في نقله، ولم يكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر.
لانه إذا كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك، كان الاعتبار بالقرينة، وكان ذلك موجبا للعلم، كما تقدمت القرائن - جاز العمل به.
والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة، فأني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الاخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعون، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشئ لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا؟
فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه، سكتوا وسلموا الامر وقبلوا قوله.
هذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي، صلى الله عليه وآله، ومن بعده من الائمة، صلوات الله عليهم، إلى زمان جعفر بن محمد، عليه السلام، الذي إنتشر عنه العلم وكثرت الرواية من جهته.
فلولا أن العمل بهذه الاخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك، لان إجماعهم فيه معصوم ولا يجوز عليه الغلط والسهو.
والذي يكشف عن ذلك: أنه لما كان العمل بالقياس محظورا عندهم في الشريعة لم يعملوا به أصلا.
وإذا شذ واحد منهم وعمل به في بعض المسائل و إستعمله على وجه المحاجة لخصمه وإن لم يكن إعتقاده، ردوا قوله، وأنكروا عليه، وتبرأوا من قوله حتى أنهم يتركون تصانيف من وصفناه ورواياته لما كان عاملا بالقياس.
فلو كان العمل بالخبر الواحد جرى بذلك المجرى لوجب فيه أيضا مثل ذلك، وقد علمنا خلافه.
فإن قيل: كيف تدعون إجماع الفرقة المحقة على العمل بخبر الواحد، والمعلوم من حالها أنها لا ترى العمل بخبر الواحد، كما أن من المعلوم أنها لا ترى العمل بالقياس.
فإن جاز إدعاء أحدهما جاز إدعاء الاخر.
قيل له: المعلوم من حالها الذي لا ينكر أنهم لا يرون العمل بخبر الواحد الذي يرويه مخالفوهم في الاعتقاد ويختصون بطريقه، فأما ما كان رواته منهم وطريقه أصحابهم، فقد بينا أن المعلوم خلاف ذلك، وبينا الفرق بين ذلك وبين القياس، وأنه لو كان معلوما حظر العمل بالخبر الواحد لجرى مجرى العلم بحظر القياس، وقد علم خلاف ذلك.
فإن قيل: " إليس شيوخكم لا يزالون يناظرون خصومهم في أن خبر الواحد لا يعمل به، ويدفعونهم عن صحة ذلك، حتى أن منهم من يقول: لا يجوز ذلك عقلا، ومنهم من يقول: لا يجوز ذلك سمعا، لان الشرع لم يرد به.
وما رأينا أحدا تكلم في جواز ذلك، ولا صنف فيه كتابا، ولا أملى فيه مسألة، فكيف أنتم تدعون خلاف ذلك؟ قيل له: من أشرت إليهم من المنكرين لاخبار الآحاد، إنما تكلموا من خالفهم
في الاعتقاد ودفعوهم من وجوب العمل بما يروونه من الاخبار المتضمنة للاحكام التي يروون خلافها.
وذلك صحيح على ما قدمناه، ولم نجدهم إختلفوا في ما بينهم، وأنكر بعضهم على بعض العمل بما يروونه إلا في مسائل دل الدليل الموجب للعلم على صحتها.
فإذا خالفوهم فيها أنكروا عليهم، لمكان الادلة الموجبة للعلم والاخبار المتواترة بخلافه.
على أن الذين أشير إليهم في السؤال أقوالهم متميزة بين اقوال الطائفة المحقة، وقد علمنا أنه لم يكونوا أئمة معصومين.
وكل قول قد علم قائله و عرف نسبه وتميز من أقاويل سائر الفرقة المحقة لم يعتد بذلك القول، لان قول الطائفة إنما كان حجة من حيث كان فيهم معصوم.
فإذا كان القول من غير معصوم علم أن قول المعصوم داخل في باقي الاقوال ووجب المصير إليه على ما بينته في الاجماع)، إنتهى موضع الحاجة من كلامه.
ثم أورد على نفسه: بأن العقل إذا جوز التعبد بخبر الواحد والشرع ورد به، فما الذي يحملكم على الفرق بين ما يرويه الطائفة المحقة وبين ما يرويه أصحاب الحديث من العامة.
ثم أجابإ عن ذلك: بأن خبر الواحد إذا كان دليلا شرعيا فينبغي أن يستعمل بحسب ما قررته الشريعة، والشارع يرى العمل بخبر طائفة خاصة فليس لنا التعدي إلى غيرها.على أن العدالة شرط في الخبر بلا خلاف.ومن خالف الحق لم يثبت عدالته، بل ثبت فسقه.
ثم أورد على نفسه: بأن العمل بخبر الواحد يوجب كون الحق من جهتين عند تعارض خبرين.
ثم أجأب: أولا، بالنقض بلزوم ذلك عند من منع العمل بخبر الواحد إذا كان هناك خبران متعارضان، فإنه يقول مع عدم الترجيح بالتخيير، فإذا اختار كلا منهما إنسان لزم كون الحق في جهتين.
وأيد ذلك: بأنه قد سئل الصادق، عليه السلام، عن إختلاف أصحابه في المواقيت وغيرها، فقال عليه السلام: (أنا خالفت بينهم).
قال بعد ذلك:
فإن قيل: كيف تعملون بهذه الاخبار ونحن نعلم أن رواتها، كما رووها، رووا أيضا أخبار الجبر والتفريض وغير ذلك من الغلو والتناسخ وغير ذلك من المناكير، فكيف يجوز الاعتماد على ما يرويه أمثال هؤلاء.
قلنا لهم: ليس كل الثقات نقل حديث الجبر والتشبيه، ولو صح أنه نقل لم يدل على أنه كان معتقدا لما تضمنه الخبر.
ولا يمتنع أن يكون إنما رواه ليعلم أنه لم يشذ عنه شئ من الروايات، لا لانه معتقد ذلك.
ونحن لم نعتمد على مجرد نقلهم، بل إعتمادنا على العمل الصادر من جهتهم وارتفاع النزاع فيما بينهم.
وأما مجرد الرواية فلا حجية فيه على حال.
فان قيل: كيف تعولون على هذه الروايات، وأكثر رواتها المجبرة والمشبهة و المقلدة والغلاة والواقفية والفطحية، وغير هؤلاء، من فرق الشيعة المخالفة للاعتقاد الصحيح، ومن شرط خبر الواحد أن يكون روايه عدلا عند من أوجب العمل به، وإن عولت على عملهم دون روايتهم فقد وجدناهم علموا بما طريقه هؤلاء الذين ذكرناهم.
وذلك يدل على جواز العمل بأخبار الكفار والفساق.
قيل لهم: لسنا نقول إن جميع أخبار الآحاد يجوز العمل بها، بل لها شرائط نذكرها فيما بعد، ونشير ههنا إلى جملة من القول فيه.
فأما ما يرويه العلماء المعتقدون للحق فلا طعن على ذلك بهم، وأما ما يرويه قوم من المقلدة فالصحيح الذى أعتقده أن المقلد للحق وإن كان مخطئا في الاصل معفو عنه ولا أحكم فيه بحكم الفساق، ولا يلزم على هذا ترك ما نقلوه.
على أن من أشار إليهم لا نسلم أنهم كلهم مقلدة، بل لا يمتنع أن يكونوا عالمين بالدليل على سبيل الجملة، كما يقوله جماعة أهل العدل في كثير من أهل الاسواق والعامة.
وليس من حيث يتعذر عليهم إيراد الحجج ينبغي أن يكونوا غير عالمين، لان إيراد الحجج والمناظرة صناعة ليس يقف حصول المعرفة على حصولها.
كما قلنا في أصحاب الجملة.
وليس لاحد أن يقول: هؤلاء ليسوا من أصحاب الجملة، لانهم إذا سئلوا عن التوحيد أو العدل أو صفات الائمة أو صحة النبوة.قالوا روينا كذا، ويروون في ذلك كله الاخبار، وليس هذا طريق أصحاب الجملة.
وذلك أنه ليس يمتنع أن يكون هؤلاء أصحاب الجملة وقد حصل لهم المعارف بالله.غير أنهم لما تعذر
عليهم إيراد الحجج في ذلك، أحالوا على ما كان سهلا عليهم.وليس يلزمهم أن يعلموا أن ذلك لا يصح أن يكون دليلا إلا بعد أن يتقدم منهم المعرفة بالله.وإنما الواجب عليهم أن يكونوا عالمين.
وهم عالمون على الجملة، كما قررنا فما يتفرع عليه من الخطأ لا يوجب التكفير ولا التضليل.
وأما الفرق الذين أشار إليهم، من الواقفية والفطحية وغير ذلك فعن ذلك جوابان).
ثم ذكر الجوابين - وحاصل أحدهما كفاية الوثاقة في العمل بالخبر.
ولهذا قبل خبر إبن بكير وبني فضال وبني سماعة، وحاصل الثاني أنا لانعمل برواياتهم إلا إذا إنضم إليها رواية غيرهم.
ومثل الجواب الاخير ذكر في رواية الغلاة ومن هو متهم في نقله.
وذكر الجوابين أيضا في روايات المجبرة والمشبهة، بعد منع كونهم مجبرة و مشبهة، لان روايتهم لاخبار الجبر والتشبيه لا تدل على ذهابهم إليه.
ثم قال: فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الذين أشرتم إليهم لم يعملوا بهذه الاخبار لمجردها، بل إنما علموا بها لقرائن إقترنت بها دلتهم على صحتها ولاجلها عملوا بها، ولو تجردت لما عملوا بها، وإذا جاز ذلك لم يمكن الاعتماد على عملهم بها.
قيل لهم: القرائن التي تقترن بالخبر وتدل على صحته أشياء مخصوصة نذكرها فيما بعد من الكتاب والسنة والاجماع والتواتر، ونحن نعلم أنه ليس في جميع المسائل التي إستعملوا فيها أخبار الآحاد ذلك، لانها أكثر من أن تحصى، لوجودها في كتبهم وتصانيفهم وفتاواهم، وليس في جميعها يمكن الاستدلال بالقرائن، لعدم ذكر ذلك في صريحه وفحواه أو دليله ومعناه، ولا في السنة المتواترة، لعدم ذكر ذلك في أكثر الاحكام، بل وجودها في مسائل معدودة، ولا في إجماع، لوجود الاختلاف في ذلك.فعلم أن دعوى القرائن في جميع ذلك دعوى محالة.
ومن ادعى القرائن في جميع ما ذكرنا كان السبر بيننا وبينه، بل كان معولا على ما يعلم ضرورة خلافه ومدعيا لما يعلم من نفسه ضده ونقيضه.
ومن قال عند ذلك: إني متى عدمت شيئا من القرائن حكمت بما كان يقتضيه العقل، يلزمه أن يترك أكثر الاخبار وأكثر الاحكام ولا يحكم فيها بشئ ورد الشرع به.
وهذا يرغب أهل العلم عنه، ومن صار إليه لا يحسن مكالمته، لانه يكون معولا على ما يعلم
ضرورة من الشرع خلافه)، إنتهى.
ثم أخذ في الاستدلال ثانيا على جواز العمل بهذه الاخبار: بأنا وجدنا أصحابنا مختلفين في المسائل الكثيرة في جميع أبواب الفقه، وكل منهم يستدل ببعض هذه الاخبار، ولم يعهد من أحد منهم تفسيق صاحبه وقطع المودة عنه، فدل ذلك على جوازه عندهم.
ثم استدل ثالثا على ذلك: بأن الطائفة وضعت الكتب لتمييز الرجال الناقلين لهذه الاخبار وبيان أحوالهم من حيث العدالة والفسق، والموافقة في المذهب و المخالفة، وبيان من يعتمد على حديثه ومن لا يعتمد، وإستثنوا الرجال من جملة ما رووه في التصانيف.وهذه عادتهم من قديم الوقت إلى حديثه.فلولا جواز العمل برواية من سلم عن الطعن لم يكن فائدة لذلك كله).إنتهى المقصود من كلامه، زاد الله في علو مقامه).
وقد أتى في الاستدلال على هذا المطلب بما لا مزيد عليه، حتى أنه أشار في جملة كلامه إلى دليل الانسداد، وأنه لو إقتصر على الادلة العلمية وعمل بأصل البراءة في غيرها لزم ما علم ضرورة من الشرع خلافه.
فشكر الله سعيه.
ثم إن من العجب أن غير واحد من المتأخرين تبعوا صاحب المعالم في دعوى عدم دلالة كلام الشيخ على حجية الاخبار المجردة عن القرينة، قال في المعالم، على ما حكي عنه: (والانصاف أنه لم يتضح من حال الشيخ وأمثاله مخالفتهم للسيد، قدس سره، إذ كانت أخبار الاصحاب يومئذ قريبة العهد بزمان لقاء المعصوم، عليه السلام، وإستفادة الاحكام منه، وكانت القرائن المعاضدة لها متيسرة، كما اشار إليه السيد، قدس سره، ولم يعلم أنه اعتمدوا على الخبر المجرد ليظهر مخالفتهم لرأيه فيه.
وتفطن المحقق من كلام الشيخ لما قلناه، قال في المعارج: (ذهب شيخنا أبوجعفر، قدس سره، إلى العمل بخبر الواحد العدل من رواة أصحابنا.
لكن لفظه وإن كان مطلقا فعند التحقيق يتبين أنه لا يعمل بالخبر مطلقا، بل بهذه الاخبار التي رويت عن الائمة، عليهم السلام، ودونها الاصحاب، لا أن كل خبر يرويه
عدل إمامي يجب العمل به.هذا هو الذي تبين لي من كلامه.ويدعى إجماع الاصحاب على العمل بهذه الاخبار.
حتى لو رواها غير الامامي وكان الخبر سليما عن المعارض واشتهر نقله في هذه الكتب الدائرة بين الاصحاب عمل به)، إنتهى.
قال، بعد نقل هذا عن المحقق: (وما فهمه المحقق من كلام الشيخ هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه، لا ما نسبه العلامة إليه)، إنتهى كلام صاحب المعالم.
وأنت خبير بأن ما ذكره في وجه الجمع، من تيسر القرائن وعدم إعتمادهم على الخبر المجرد، قد صرح الشيخ في عبارته المتقدمة ببداهة بطلانه، حيث قال: (إن دعوى القرائن في جميع ذلك دعوى محالة، فأن المدعي لها معول على ما يعلم ضرورة خلافه ويعلم من نفسه ضده ونقيضه).
و الظاهر بل المعلوم أنه، قدس سره، لم يكن عنده كتاب العدة.
وقال المحدث الاسترابادي في محكي الفوائد المدنية: (إن الشيخ، قدس سره، لا يجيز العمل إلا بالخبر المقطوع بصدوره عنهم.وذلك هو مراد المرتضى، قدس سره، فصارت المناقشة لفظية، لا كما توهمه العلامة ومن تبعه).
إنتهى كلامه.
وقال بعض من تأخر عنه من الاخباريين في رسالته، بعدما استحسن ما ذكره صاحب المعالم: (ولقد أحسن النظر وفهم طريقة الشيخ والسيد، قدس سرهما، من كلام المحقق، قدس سره، كما هو حقه.
والذي يظهر منه أنه لم ير عدة الاصول للشيخ، وإنما فهم ذلك مما نقله المحقق، قدس سره، ولو رآها لصدع بالحق أكثر من هذا.وكم له من تحقيق أبان من غفلات المتأخرين، كوالده وغيره.وفيما ذكره كفاية لمن طلب الحق وعرفه.
وقد تقدم كلام الشيخ، وهو صريح فيما فهمه المحقق، قدس سره، وموافق لما يقوله السيد، قدس سره، فليراجع.
والذي أوقع العلامة في هذا الوهم ما ذكره الشيخ في العدة، من أنه يجوز العمل بخبر العدل الامامي، ولم يتأمل بقية الكلام، كما تأمله المحقق، ليعلم أنه إنما يجوز العمل بهذه الاخبار التي روتها الاصحاب واجتمعوا على جواز العمل بها.
وذلك مما يوجب العلم بصحتها، لا ان كل خبر يرويه عدم إمامي يجب العمل
به، وإلا فكيف يظن بأكابر الفرقة الناجية وأصحاب الائمة، صلوات الله عليهم - مع قدرتهم على أخذ اصول الدين وفروعه منهم - عليهم السلام - بطريق اليقين: أن يعولوا فيهما على أخبار الآحاد المجردة.
مع أن مذهب العلامة وغيره أنه لا بد في أصول الدين من الدليل القطعي وأن المقلد في ذلك خارج عن ربقة الاسلام.
وللعلامة وغيره كثير من هذا الغفلات لالفة أذهانهم بأصول العامة.
ومن تتبع كتب القدماء وعرف أحوالهم، قطع بأن الاخباريين من أصحابنا لم يكونوا يعولون في عقائدهم إلا على الاخبار المتواترة أو الآحاد المحفوفة بالقرائن المفيدة للعلم.
وأما خبر الواحد فيوجب عندهم الاحتياط دون القضاء والافتاء، والله الهادي)، إنتهى كلامه.
أقول: أما دعوى دلالة كلام الشيخ في العدة على عمله بالاخبار المحفوفة بالقرائن العلمية دون االمجردة عنها، وأنه ليس مخالفا للسيد، قدس سرهما، فهو كمصادمة الضرورة، فإن في العبارة المتقدمة من العدة، وغيرها مما لم نذكرها، مواضع تدل على مخالفة السيد، نعم يوافقه في العمل بهذه الاخبار المدونة.
إلا أن السيد يدعي تواترها له واحتفافها بالقرينة المفيدة للعلم، كما صرح به في محكي كلامه، في جواب المسائل التبانيات، من: (أن أكثر أخبارنا المروية في كتبنا معلومة مقطوع على صحتها، إما بالتواتر أو بأمارة وعلامة تدل على صحتها وصدق رواتها، فهي موجبة للعلم مفيدة للقطع وإن وجدناها في الكتب مودعة بسند مخصوص من طريق الآحاد)، إنتهى.
والشيخ يأبى عن إحتفافها بها، كما عرفت من كلامه السابق في جواب ما أورده على نفسه، بقوله: (فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الذين أشرتم إليهم لم يعملوا بهذه الاخبار بمجردها، بل إنما عملوا بها لقرائن إقترنت بها دلتهم على صحتها)، إلى آخر ما ذكره.
ومجرد عمل السيد والشيخ بخبر خاص - لدعوى الاول تواتره، والثاني كون خبر الواحد حجة - لا يلزم منه توافقهما في مسألة حجية خبر الواحد.
فإن الخلاف فيها يثمر في خبر يدعي السيد تواتره ولا يراه الشيخ جامعا لشرائط الخبر المعتبر وفي خبر يراه الشيخ جامعا ولم يحصل تواتره للسيد، إذ ليس جميع ما دون في الكتب متواترا عند السيد ولا جامعا لشرائط الحجية عند الشيخ.
ثم إن إجماع الاصحاب الذي إدعاه الشيخ على العمل بهذه الاخبار لا يصير قرينة لصحتها بحيث تفيد العلم حتى كون حصول الاجماع للشيخ قرينة عامة لجميع هذه الاخبار.
كيف وقد عرفت إنكاره للقرائن حتى لنفس المجمعين ولو فرض كون الاجماع على العمل قرينة، لكنه غير حاصل في كل خبر بحيث يعلم أو يظن أن هذا الخبر بالخصوص، وكذا ذاك وذاك مما اجمع على العمل به، كما لا يخفى.
بل المراد الاجماع على الرجوع إليها والعمل بها بعد حصول الوثوق من الراوي أو من القرائن.
ولذا إستثنى القميون كثيرا من رجال نوادر الحكمة، مع كونه من الكتب المشهورة المجمع على الرجوع إليها، واستثنى إبن الوليد من روايات العبيدي ما يرويها عن يونس، مع كونها في الكتب المشهورة.
والحاصل أن معنى الاجماع على العمل بها عدم ردها من جهة كونها أخبار آحاد، لا الاجماع [ على العمل ] بكل خبر منها.
ثم إن ما ذكره - من تمكن أصحاب الائمة، عليهم السلام، من أخذ الاصول والفروع بطريق اليقين - دعوى ممنوعة واضحة المنع.
وأقل ما يشهد عليها ما علم بالعين والاثر من إختلاف أصحابهم - صلوات الله عليهم - في الاصول والفروع، ولذا شكى غير واحد من أصحاب الائمة، عليهم السلام، إليهم إختلاف أصحابهم، فأجابوهم تارة بأنهم، عليهم السلام، قد ألقوا الاختلاف بينهم حقنا لدمائهم، كما في رواية حريز وزرارة وأبي أيوب الخزاز، وأخرى أجابوهم بأن ذلك من جهة الكذابين، كما في رواية فيض بن المختار: (قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: جعلني الله فداك، ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم؟ قال: (وأي الاختلاف؟ يا فيض !)، قلت له: إني أجلس في حلقهم بالكوفة وأكاد أشك في إختلافهم في حديثهم، حتى أرجع إلى المفضل بن عمر، فيوقفني من ذلك على ما تستريح به نفسي.
فقال عليه السلام: أجل، كما ذكرت يا فيض ! إن الناس قد أولعوا بالكذب علينا، كأن الله إفترض عليهم ولا يريد منهم غيره.
إني أحدث أحدهم بحديث، فلا يخرج من عندي حتى يتأوله على غير تأويله.
وذلك لانهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند الله تعالى، وكل يحب أن يدعى رأسا).
وقريب منها: رواية داود بن سرحان، وإستثناء القميين كثيرا من رجال نوادر الحكمة معروف،
وقصة إبن أبي العوجاء أنه قال عند قتله: (قد دسست في كتبكم أربعة آلاف حديث) مذكورة في الرجال.
وكذا ما ذكره يونس بن عبدالرحمن، من أنه أحاديث كثيرة من أصحاب الصادقين، عليهما السلام ثم عرضها على أبي الحسن الرضا، عليه السلام، فانكر منها أحاديث كثيرة، إلى غير ذلك مما يشهد بخلاف ما ذكره.
وأما ما ذكره - من عدم الاخباريين في عقائدهم إلا على الاخبار المتواترة والآحاد العلمية - ففيه: أن الاظهر في مذهب الاخباريين ما ذكره العلامة، من أن الاخباريين لم يعولوا في أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد.
ولعلهم المعنيون مما ذكره الشيخ في كلامه السابق في المقلدة، أنهم إذا سئلوا عن التوحيد وصفات الائمة والنبوة، قالوا: روينا كذا، وأنهم يروون في ذلك الاخبار.
وكيف كان، فدعوى دلالة كلام الشيخ في العدة على موافقة السيد، في غاية الفساد.
لكنها غير بعيدة ممن يدعي قطعية صدور أخبار الكتب الاربعة، لانه إذا ادعى القطع لنفسه بصدور الاخبار التي أودعها الشيخ في كتابيه، فكيف يرضى للشيخ ومن تقدم عليه من المحدثين أن يعملوا بالاخبار المجردة عن القرينة.
وأما صاحب المعالم، قدس سره، فعذره أنه لم يحضره عدة الشيخ حين كتابة هذا الموضع، كما حكي عن بعض حواشيه واعترف به هذا الرجل.
وأما المحقق، قدس سره، فليس في كلامه المتقدم منع دلالة كلام الشيخ على حجية خبر الواحد المجرد مطلقا، وإنما منع من دلالته على الايجاب الكلي، وهو أن كل خبر يرويه عدل إمامي يعمل به، وخص مدلوله بهذه الاخبار التي دونها الاصحاب وجعله موافقا لما إختاره في المعتبر من التفصيل في أخبار الآحاد المجردة بعد ذكر الاقوال فيها، وهو: (أن ما قبله الاصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به، وما أعرض الاصحاب عنه أو شذ يجب طرحه) إنتهى.
والانصاف: أن ما فهمه العلامة من إطلاق قول الشيخ بحجية خبر العدل الامامي أظهر مما فهمه المحقق من التقييد، لان الظاهر أن الشيخ إنما يتمسك بالاجماع على العمل بالروايات المدونة في كتب الاصحاب على حجية مطلق خبر العدل الامامي، بناء منه على أن الوجه في عملهم بها كونها أخبار عدول.
وكذا ما ادعاه من الاجماع على العمل بروايات الطوائف الخاصة من غير الامامية، وإلا فلم يأخذه في عنوان مختاره ولم يشترط كون الخبر مما رواه الاصحاب وعملوا به،
فراجع كلام الشيخ وتأمله، والله العالم، وهو الهادي إلى الصواب.
ثم إنه لا يبعد وقوع مثل هذا التدافع بين دعوى السيد ودعوى الشيخ، مع كونهما معاصرين خبيرين بمذهب الاصحاب في العمل بخبر الواحد.
فكم من مسألة فرعية وقع الاختلاف بينهما في دعوى الاجماع فيها.
مع أن المسألة الفرعية أولى بعدم خفاء مذهب الاصحاب فيها عليهما، لان المسائل الفرعية معنونة في الكتب مفتى بها غالبا بالخصوص.
نعم قد يتفق دعوى الاجماع بملاحظة قواعد الاصحاب، والمسائل الاصولية لم تكن معنونة في كتبهم.
إنما المعلوم من حالهم أنهم عملوا بأخبار وطرحوا أخبارا.
فلعل وجه عملهم بما عملوا كونه متواترا أو محفوفا عندهم، بخلاف ما طرحوا، على ما يدعيه السيد، قدس سره، على ما صرح به في كلامه المتقدم، من أن الاخبار المودعة في الكتب بطريق الآحاد متواترة أو محفوفة.
ونص في مقام آخر على أن معظم الاحكام يعلم بالضرورة والاخبار المعلومة.
ويحتمل كون الفارق بين ما عملوا وما طرحوا مع إشتراكهما في عدم التواتر والاحتفاف فقد شرط العمل في أحدهما دون الاخر على ما يدعيه الشيخ، قدس سره، على ما صرح به في كلامه المتقدم، من الجواب عن إحتمال كون عملهم بالاخبار لاقترانها بالقرائن.
نعم لا يناسب ما ذكرنا من الوجه تصريح السيد بأنهم شددوا الانكار على العامل بخبر الواحد.
ولعل الوجه فيه: ما اشار إليه الشيخ في كلامه المتقدم بقوله: (إنهم منعوا من الاخبار التي رواها المخالفون في المسائل التي روى أصحاب خلافها).
واستبعد هذا صاحب المعالم في حاشية منه على هامش المعالم، بعدما حكاه عن الشيخ: (بأن الاعتراف بانكار عمل الامامية بأخبار الآحاد لا يعقل صرفه إلى روايات مخالفيهم، لان إشتراط العدالة عندهم وإنتفاءها في غيرهم كاف في الاضراب عنها، فلا وجه للمبالغة في نفي العمل بخبر يروونه)، إنتهى.
وفيه: أنه يمكن أن يكون إظهار هذا المذهب للتجنن به في مقام لا يمكنهم التصريح بفسق الراوي، فاحتالوا في ذلك بأنا لا نعمل إلا بما حصل لنا القطع بصدقه بالتواتر أو بالقرائن، ولا دليل عندنا على العمل بالخبر الظني وإن كان راويه غير مطعون.
وفي عبارة الشيخ المتقدمة إشارة
إلى ذلك حيث خص إنكار الشيوخ للعمل بالخبر المجرد بصورة المناظرة مع خصومهم.
والحاصل: أن الاجماع الذي ادعاه السيد، قدس سره، قولي، وما إدعاه الشيخ، قدس سره، إجماع عملي، والجمع بينهما يمكن بحمل عملهم على ما احتف بالقرينة عندهم، وبحمل قولهم على ما ذكرنا من الاحتمال في دفع الروايات الواردة فيما لا يرضونه من المطالب.
والحمل الثاني مخالف لظاهر القول، والحمل الاول ليس مخالفا لظاهر العمل، لان العمل مجمل من أجل الجهة التي وقع عليها.
إلا أن الانصاف: أن القرائن تشهد بفساد الحمل الاول، كما سيأتي.
فلا بد من حمل قول من حكى عنهم السيد المنع، إما على ما ذكرنا، من إرادة دفع أخبار المخالفين التي لا يمكنهم ردها بفسق الراوي، وإما على ما ذكره الشيخ، من كونهم جماعة معلومي النسب لا يقدح مخالفتهم بالاجماع.
ويمكن الجمع بينهما بوجه آخر: وهو أن مراد السيد، قدس سره، من العلم الذي إدعاه في صدق الاخبار هو مجرد الاطمينان، فإن المحكي عنه، قدس سره، في تعريف العلم أنه ما اقتضى سكون النفس.
وهو الذي ادعى بعض الاخباريين أن مرادنا بالعلم بصدور الاخبار هو هذا المعنى، لا اليقين الذي لا يقبل الاحتمال رأسا.
فمراد الشيخ من تجرد هذه الاخبار عن القرائن تجردها عن القرائن الاربع التي ذكرها أولا، وهي موافقة الكتاب أو السنة أو الاجماع أو دليل العقل.
ومراد السيد من القرائن التي إدعى في عبارته المتقدمه إحتفاف أكثر الاخبار بها هي الامور الموجبة للوثوق بالراوي أو بالرواية بمعنى سكون النفس بهما وركونها إليهما.
وحينئذ فيحمل إنكار الامامية للعمل بخبر الواحد على إنكارهم للعمل به تعبدا، أو لمجرد حصول رجحان بصدقه على ما يقوله المخالفون.
والانصاف: أنه لم يتضح من كلام الشيخ دعوى الاجماع على أزيد من الخبر الموجب لسكون النفس ولو بمجرد وثاقة الراوى وكونه سديدا في نقله لم يطعن في روايته.
ولعل هذا الوجه أحسن وجوه الجمع بين كلامي الشيخ والسيد، قدس سرهما، خصوصا مع ملاحظة تصريح السيد، قدس سره، في كلامه بأن أكثر الاخبار متواترة أو محفوفة، وتصريح الشيخ، قدس سره، في كلامه المتقدم بإنكار ذلك.
وممن نقل الاجماع على حجية أخبار الآحاد: السيد الجليل رضي الدين إبن طاووس، حيث قال في جملة كلام له يطعن فيه على السيد، قدس سره،: (ولا يكاد تعجبي ينقضى كيف إشتبه عليه أن الشيعة تعمل بأخبار الآحاد
في الامور الشرعية، ومن إطلع على التواريخ والاخبار وشاهد عمل ذوي الاعتبار، وجد المسلمين والمرتضى وعلماء الشيعة الماضين عاملين بأخبار الآحاد بغير شبهة عند العارفين، كما ذكر محمد بن الحسن الطوسي في كتاب العدة وغيره من المشغولين بتصفح أخبار الشيعة وغيرهم من المصنفين)، إنتهى.
وفيه دلالة على أن غير الشيخ من العلماء أيضا إدعى الاجماع على عمل الشيعة بأخبار الآحاد.
وممن نقل الاجماع أيضا العلامة، رحمه الله، في النهاية حيث قال: (إن الاخباريين منهم لم يعولوا في أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد، و الاوصوليين منهم، كأبي جعفر الطوسي عمل بها ولم ينكره سوى المرتضى وأتباعه، لشبهة حصلت لهم)، إنتهى.
وممن إدعاه أيضا المحدث المجلسي، قدس سره، في بعض رسائله، حيث إدعى تواتر الاخبار و عمل الشيعة في جميع الاعصار على العمل بخبر الواحد.
ثم إن مراد العلامة، قدس سره، من الاخباريين يمكن أن يكون مثل الصدوق وشيخه ، قدس سرهما، حيث أثبتا السهو للنبي، صلى الله عليه وآله، والائمة، عليهم السلام، لبعض أخبار الآحاد، وزعما أن نفيه عنهم، عليهم السلام، أول درجة في الغلو، ويكون ما تقدم في كلام الشيخ من المقلدة الذين إذا سئلوا عن التوحيد وصفات النبي " ص " والائمة عليهم السلام قالوا: روينا كذا، ورووا في ذلك الاخبار.
وقد نسب الشيخ، قدس سره، في هذا المقام من العدة العمل بأخبار الآحاد في أصول الدين إلى بعض غفلة أصحاب الحديث.
ثم إنه يمكن أن يكون الشبهة التي ادعى العلامة، قدس سره، حصولها للسيد وأتباعه هو زعم الاخبار التي عمل بها الاصحاب ودونوها في كتبهم محفوفة عندهم بالقرائن، أو أن من قال من شيوخهم بعدم حجية أخبار الآحاد أراد بها مطلق الاخبار، حتى الاخبار الواردة من طرق أصحابنا مع وثاقة الراوي، أو أن مخالفته لاصحابنا في هذه المسألة لاجل شبهة حصلت له، فخالف المتفق عليه بين الاصحاب.
ثم إن دعوى الاجماع على العمل بأخبار الآحاد، وإن لم يطلع عليها صريحة في كلام غير الشيخ
وإبن طاووس والعلامة والمجلسي، قدست أسرارهم، إلا أن هذه الدعوى منهم مقرونة بقرائن تدل على صحتها وصدقها، فخرج عن الاجماع المنقول بخبر الواحد المجرد عن القرينة ويدخل في المحفوف بالقرينة، وبهذا الاعتبار يتمسك بها على حجية الاخبار.
بل السيد، قدس سره، قد إعترف في بعض كلامه المحكي، كما يظهر منه، بعمل الطائفة بأخبار الآحاد، إلا أنه يدعي أنه لما كان من المعلوم عدم علمهم بالاخبار المجردة، كعدم علمهم بالقياس، فلا بد من حمل موارد عملهم على الاخبار المحفوفة.
قال في الموصليات، على ما حكي عنه في محكي السرائر: (إن قيل: أليس شيوخ هذا الطائفة عولوا في كتبهم في الاحكام الشرعية على الاخبار التي رووها عن ثقاتهم وجعلوها العمدة والحجة في الاحكام حتى رووا عن ائمتهم، عليهم السلام، فيما يجئ مختلفا من الاخبار عند عدم الترجيح أن يؤخذ منه ما هو أبعد من قول العامة، وهذا يناقض ما قدمتموه.
قلنا: ليس ينبغي أن يرجع عن الامور المعلومة المشهورة المقطوع عليها إلى ما هو مشتبه وملتبس ومجمل، وقد علم كل موافق ومخالف أن الشيعة الامامية تبطل القياس في الشريعة حيث لا يؤدي إلى العلم، وكذلك نقول في أخبار الآحاد)، إنتهى المحكي عنه.
وهذا الكلام، كما ترى، يظهر منه عمل الشيوخ بأخبار الآحاد، إلا أنه، قدس سره، إدعى معلومية خلافه من مذهب الامامية، فترك هذا الظهور أخذا بالمقطوع، ونحن نأخذ بما ذكره أولا، لاعتضاده بما يوجب الصدق، دون ما ذكره أخيرا، لعدم ثبوته إلا من قبله.
وكفى بذلك موهنا، بخلاف الاجماع المدعى من الشيخ والعلامة، فإنه معتضد بقرائن كثيرة تدل على صدق مضمونها وأن الاصحاب عملوا بالخبر الغير العلمي في الجملة: فمن تلك القرائن: ما إدعاه الكشي من إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة.
فإن من المعلوم أن معنى التصحيح المجمع عليه هو عد خبره صحيحا، بمعنى علملهم به، لا القطع بصدوره، إذ الاجماعه وقع على التصحيح، لا على الصحة، مع أن الصحة عندهم على ما صرح به غير واحد عبارة عن الوثوق والركون، لا القطع واليقين.
ومنها: دعوى النجاشي أن مراسيل إبن أبي عمير مقبولة عند الاصحاب.
وهذه العبارة تدل على عمل الاصحاب بمراسيل مثل إبن أبي عمير، لا من أجل القطع بالصدور، بل لعلمهم أنه لا يروي أو لا يرسل إلا عن ثقة.
فولا قبولهم لما يسنده الثقة إلى الثقة لم يكن وجه لقبول مراسيل إبن أبي عمير الذي لا يروي إلا عن الثقة، والاتفاق المذكور قد إدعاه الشهيد في الذكرى أيضا.
وعن كاشف الرموز تلميذ المحقق: أن الاصحاب عملوا بمراسيل البزنطي.
ومنها: ما ذكره إبن إدريس في رسالة خلاصة الاستدلال التي صنفها في مسألة فورية القضاء، في مقام دعوى الاجماع على المضايقة وأنها مما أطبقت عليه الامامية إلا نفر يسير من الخراسانيين، قال في مقام تقريب الاجماع: (إن إبني بابويه، والاشعريين، كسعد به عبدالله وسعيد بن سعد ومحمد بن علي بن محبوب، والقميين أجمع، كعلي بن إبراهيم ومحمد بن الحسن بن الوليد، عاملون بالاخبار المتضمنة للمضايقة، لانهم ذكروا أنه لا يحل رد الخبر الموثوق برواته) إنتهى.
فقد استدل على مذهب الامامية بذكرهم لاخبار المضايقة وذهابهم إلى العمل برواية الثقة، فاستنتج من هاتين المقدمتين ذهابهم إلى المضايقة.
وليت شعري إذا علم إبن إدريس أن مذهب هؤلاء - الذين هم أصحاب الائمة، عليهم السلام، ويحصل العلم بقول الامام، عليه السلام، من إتفاقهم - وجوب العمل برواية الثقة وأنه لا يحل ترك العمل بها، فكيف تبع السيد في مسألة خبر الواحد، إلا أن يدعى أن المراد بالثقة من يفيد قوله القطع - وفيه ما لا يخفى - أو يكون مراده ومراد السيد، قدس سرهما، من الخبر العلمي ما يفيد الوثوق والاطمينان، لا ما يوجب اليقين، على ما ذكرناه سابقا في الجمع بين كلامي السيد والشيخ، قدس سرهما.
ومنها: ما ذكره المحقق في المعتبر، في مسألة خبر الواحد، حيث قال: (أفرط الحشوية في العمل بخبر الواحد حتى إنقادوا لكل خبر، وما فطنوا لما تحته من التناقض، فإن من جملة الاخبار قول النبي صلى الله عليه وآله: (ستكثر بعدي القالة علي)، وقول الصادق عليه السلام: (إن لكل رجل منا رجلا يكذب
عليه).وإقتصر بعضهم عن هذا الافراط فقال: (كل سليم السند يعلم به).
وما علم أن الكاذب قد يصدق، ولم يتنبه على أن ذلك طعن في علماء الشيعة وقدح في المذهب، إذ ما من مصنف إلا وهو يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل.
وأفرط آخرون في طريق رد الخبر حتى أحالوا إستعماله عقلا.
واقتصر آخرون، فلم يروا العقل مانعا، لكن الشرع لم يأذن في العمل به.
وكل هذه الاقوال منحرفة عن السنن.
والتوسط أقرب، فما قبله الاصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به، وما أعرض عنه الاصحاب أو شذ يجب إطراحه) إنتهى.
وهو - كما ترى - ينادي بأن علماء الشيعة قد يعملون بخبر المجروج كما يعملون بخبر العدل.
وليس المراد عملهم بخبر المجروح والعدل إذا أفاد العلم بصدقه، لان كلامه في الخبر الغير العلمي، وهو الذي أحال قوم إستعماله عقلا ومنعه آخرون شرعا.
ومنها: ما ذكره الشهيد في الذكرى، والمفيد الثاني ولد شيخنا الطوسي، من أن الاصحاب قد عملوا بشرائع الشيخ أبي الحسن علي بن بابويه عند إعواز النصوص تنزيلا لفتاواه منزلة رواياته.
ولولا عمل الاصحال برواياته الغير العلمية لم يكن وجه للعمل بتلك الفتاوى عند عدم رواياته.
ومنها: ما ذكره المجلسي في البحار في تأويل بعض الاخبار التي تقدم ذكرها في دليل السيد وأتباعه مما دل على المنع من العمل بالخبر الغير المعلوم الصدور، من: (أن عمل أصحاب الائمة، عليهم السلام، بالخبر الغير العلمي متواتر بالمعنى).
ولا يخفى: أن شهادة مثل هذا المحدث الخبير الغواص في بحار أنوار أخبار الائمة الاطهار بعمل أصحاب الائمة، عليهم السلام، بالخبر الغير العلمي، ودعواه حصول القطع له بذلك من جهة التواتر، لا يقصر عن دعوى الشيخ والعلامة الاجماع على العمل بأخبار الآحاد.
وسيأتي أن المحدث الحر العاملي في الفصول المهمه إدعى أيضا تواتر الاخبار بذلك.
ومنها: ما ذكره شيخنا البهائي في مشرق الشمسين من: (أن الصحيح عند القدماء ما كان محفوفا بما يوجب ركون النفس إليه).
وذكر فيما يوجب الوثوق أمورا لا تفيد إلا الظن، ومعلوم أن الصحيح عندهم هو المعمول به، وليس هذا مثل الصحيح عند المتأخرين في أنه قد لا يعمل به، لاعراض الاصحاب عنه أو لخلل آخر.
فالمراد أن المقبول عندهم ما تركن إليه النفس وتثق به.
هذا ما حضرني من كلمات الاصحاب، الظاهرة في دعوى الاتفاق على العمل بخبر الواحد الغير العلمي في الجملة، المؤيدة لما إدعاه الشيخ والعلامة.
وإذا ضممت إلى ذلك كله ذهاب معظم الاصحاب بل كلهم، عدا السيد وأتباعه، من زمان الصدوق إلى زماننا هذا، إلى حجية الخبر الغير العلمي، حتى أن الصدوق تابع في التصحيح والرد لشيخه إبن الوليد، وأن ما صححه فهو صحيح وأن ما رده فهو مردود، كما صرح به في صلاة الغدير في الخبر الذي رواه في العيون عن كتاب الرحمة، ثم ضممت إلى ذلك ظهور عبارة أهل الرجال في تراجم كثير من الرواة في كون العمل بالخبر الغير العلمي مسلما عندهم، مثل قولهم: فلان لا يعتمد على ما ينفرد به، وفلان مسكون في روايته، وفلان صحيح الحديث، والطعن في بعض بأنه يعتمد الضعفاء والمراسيل، إلى غير ذلك، وضممت إلى ذلك ما يظهر من بعض أسؤلة الروايات السابقة، من أن العمل بالخبر الغير العلمي كان مفروغا عنه عند الرواة - تعلم علما يقينا صدق ما ادعاه الشيخ من إجماع الطائفة.
والانصاف: أنه لم يحصل في مسألة يدعي فيها الاجماع من الاجماعات المنقولة والشهرة العظيمة القطعية والامارات الكثيرة الدالة على العمل ما حصل في هذه المسألة، فالشاك في تحقق الاجماع في هذه المسألة، لا أراه يحصل له الاجماع في مسألة من المسائل الفقهية، اللهم إلا في ضروريات المذهب.
لكن الانصاف: أن المتيقن من هذا كله الخبر المفيد للاطمينان، لا مطلق الظن.ولعله مراد السيد من العلم، كما أشرنا إليه آنفا.
بل ظاهر كلام بعض إحتمال أن يكون مراد السيد، قدس سره، من خبر غير مراد الشيخ، قدس سره.
قال الفاضل القزويني في لسان الخواص، على ما حكي عنه: (إن هذه الكلمة، أعني خبر الواحد، على ما يستفاد من تتبع كلماتهم، يستعمل في ثلاثة معان: أحدهما الشاذ النادر الذي لم يعمل به أحد، أو ندر من يعمل به، ويقابله ما
عمل به كثيرون.
الثاني: ما يقابل المأخوذ من الثقات المحفوظ في الاصول المعمولة عند جميع خواص الطائفة، فيشمل الاول ومقابله.
الثالث: ما يقابل المتواتر القطعي الصدور، وهذا يشمل الاولين وما يقابلهما).
ثم ذكر ما حاصله: (إن ما نقل إجماع الشيعة على إنكاره هو الاول، وما انفرد السيد، قدس سرة، برده هو الثاني.
وأما الثالث: فلم يتحقق من أحد نفيه على الاطلاق)، إنتهى.
وهو كلام حسن.
وأحسن منه ما قدمناه، من أن المراد السيد من العلم ما يشمل الظن الاطميناني، كما يشهد به التفسير المحكي عنه للعلم: بأنه ما اقتضى سكون النفس، والله العالم.
الثاني: من وجوه تقرير الاجماع أن يدعي الاجماع، حتى من السيد وأتباعه، على وجوب العمل بالخبر الغير العلمي، في زماننا هذا وشبهه مما انسد فيه باب القرائن المفيدة للعلم بصدق الخبر، فإن الظاهر أن السيد إنما منع من ذلك لعدم الحاجة إلى خبر الواحد المجرد.
كما يظهر من كلامه المتضمن للاعتراض على نفسه، بقوله: (فإن قلت: إذا سددتم طريق العمل بأخبار الآحاد، فعلى أي شئ تعولون في الفقه كله).
فأجاب بما حاصله: إن معظم الفقه يعلم بالضرورة والاجماع والاخبار العلمية.
وما يبقى من المسائل الخلافية يرجع فيها إلى التخيير).
وقد إعترف السيد، رحمه الله، في بعض كلامه على ما في المعالم، بل وكذا الحلي في بعض كلامه، على ما هو ببالي: بأن العمل بالظن متعين فيما لا سبيل فيه إلى العلم.
الثالث: من وجوه تقرير الاجماع إستقرار سيرة المسلمين طرا على إستفادة الاحكام الشرعية من أخبار الثقات المتوسطة بينهم و بين الامام، عليه السلام، أو المجتهد.
أترى أن المقلدين يتوقفون في العمل بما يخبرهم الثقة عن المجتهد، أو الزوجة تتوقف فيما يحيكه زوحها من المجتهد في مسائل حيضها وما يتعلق بها إلى أن يعلموا من المجتهد تجويز العمل بالخبر الغير
العلمي؟ وهذا مما لا شك فيه.ودعوى حصول القطع لهم في جميع الموارد بعيدة عن الانصاف.
نعم المتيقن من ذلك صورة حصول الاطمينان بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف.
وقد حكي إعتراض السيد، قدس سره، على نفسه: ب (أنه لا خلاف بين الامة في أن من وكل وكيلا أو إستناب صديقا في إبتياع أمة أو عقد على إمرأة في بلدته أو في بلاد نائية - فحمل إليه الجارية وزف إليه المرأة، وأخبره أنه أزاح العلة في ثمن الجارية ومهر المرأة وأنه اشترى هذه وعقد على تلك: - إن له وطئها والانتفاع بها في كل ما يسوغ للمالك والزوج.
وهذه سبيله مع زوجته وأمته إذ أخبرته بطهرها وحيضها، ويرد الكتاب على المرأة بطلاق زوجها أو بموته فتتزوج، وعلى الرجل بموت إمرأته، فيتزوج أختها.
وكذا لا خلاف بين الامة في أن للعالم أن يفتي وللعامي أن يأخذ منه مع عدم علم أن ما أفتى به من شريعة الاسلام وأنه مذهبه).
فأجاب بما حاصله: (إنه إن كان الغرض من هذه الرد على من أحال التعبد بخبر الواحد فمتوجه، فلا محيص، وإن كان الغرض الاحتجاج به على وجوب العمل بأخبار الآحاد في التحليل والتحريم، فهذه مقامات ثبت فيها التعبد بأخبار الآحاد من طرق علمية من إجماع وغيره على أنحاء مختلفة، في بعضها لا يقبل إلا إخبار أربعة، وفي بعضها لا يقبل إلا عدلان، وفي بعضها يكفي قول العدل الواحد، وفي بعضها يكفي خبر الفاسق والذمي، كما في الوكيل ومبتاع الامة والزوجة في الحيض والطهر.
وكيف يقاس على ذلك رواية الاخبار في الاحكام).
أقول: المعترض، حيث إدعى الاجماع على العمل في الموارد المذكورة، فقد لقن الخصم طريق إلزامه والرد عليه بأن هذه الموارد للاجماع ولو إدعى إستقرار سيرة المسلمين على العمل في الموارد المذكورة وإن لم يطلعوا على كون ذلك إجماعا عند العلماء كان أبعد عن الرد، فتأمل.
الرابع: [ من وجوه تقرير الاجماع ] إستقرار طريقة العقلاء طرا على الرجوع إلى خبر الثقة في أمورهم العادية، ومنها الاوامر الجارية من الموالي إلى العبيد.
فنقول: إن الشارع إن إكتفى بذلك منهم في الاحكام الشرعية فهو، وإلا وجب عليه ردعهم و تنبيههم على بطلان سلوك هذا الطريق في الاحكام الشرعية، كما ردع في مواضع خاصة.
وحيث لم يردع علم منه رضاه بذلك، لان اللازم في باب الاطاعة والمعصية الاخذ بما يعد طاعة في العرف و ترك ما يعد معصية، كذلك.
فإن قلت: يكفي في ردعهم الايات المتكاثرة والاخبار المتظافرة بل المتواترة على حرمة العمل بما عدا العلم.
قلت: قد عرفت إنحصار دليل حرمة العمل بما عدا العلم في أمرين وأن الايات والاخبار راجعة إلى أحدهما.
الاول: أن العمل بالظن والتعبد به من دون توقيف من الشارع تشريع محرم بالادلة الاربعة.
والثاني أن فيه طرحا لادلة الاصول العملية واللفظية التي إعتبرها الشارع عند عدم العلم بخلافها.
وشئ من هذين الوجهين لا يوجب ردعهم عن العمل، لكون حرمة العمل بالظن من أجلهما مركوزا في ذهن العقلاء، لان حرمة التشريع ثابت عندهم، والاصول العملية واللفظية معتبرة عندهم، مع عدم الدليل على الخلاف.
ومع ذلك نجد بناءهم على العمل بالخبر الموجب للاطمينان.
والسر في ذلك عدم جريان الوجهين المذكورين بعد إستقرار سيرة العقلاء على العمل بالخبر، لانتفاء التشريع، مع بناءهم على سلوكه في مقام الاطاعة والمعصية، فإن الملتزم بفعل ما أخبر الثقة بوجوبه وترك ما أخبر بحرمته لا يعد مشرعا، بل لا يشكون في كونه مطيعا، ولذا يعولون عليه في أوامرهم العرفية من الموالي إلى العبيد، مع أن قبح التشريع عند العقلاء لا يختص بالاحكام الشرعية.
وأما الاصول المقابلة للخبر، فلا دليل على جريانها في مقابل خبر الثقة، لان الاصول التي مدركها حكم العقل، لا الاخبار، لقصورها عن إفادة إعتبارها، كالبراءة والاحتياط والتخيير، لا إشكال في عدم جريانها في مقابل خبر الثقة، بعد الاعتراف ببناء العقلاء على العمل به في أحكامها العرفية، لان نسبة العقل في حكمه بالعمل بالاصول المذكورة إلى الاحكام الشرعية و العرفية سواء.
وأما الاستصحاب، فإن أخذ من العقل فلا إشكال في أنه لا يفيد الظن في المقام، وإن أخذ من الاخبار فغاية الامر حصول الوثوق بصدورها دون اليقين.
وأما الاصول اللفظية، كالاطلاق والعموم، فليس بناء أهل اللسان على إعتبارها حتى في
مقام وجود الخبر الموثوق به في مقابلها، فتأمل.
الخامس: [ من وجوه تقرير الاجماع ] ما ذكره العلامة في النهاية من إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد من غير نكير، وقد ذكر في النهاية مواضع كثيرة عمل فيها الصحابة بخبر الواحد.
وهذا الوجه لا يخلو من تأمل، لانه إن أريد من الصحابة العاملين بالخبر من كان في ذلك الزمان لا يصدر إلا عن رأي الحجة، عليه السلام، فلم يثبت عمل أحد منهم بخبر الاحد فضلا عن ثبوت تقرير الامام عليه السلام له، وإن أريد به الهمج الرعاع الذين يصغون إلى كل ناعق، فمن المقطوع عدم كشف عملهم عن رضاء الامام، عليه السلام، لعدم إرتداعهم بردعه في ذلك اليوم.
ولعل هذا مراد السيد، قدس سره، حيث أجاب عن هذا الوجه بأنه إنما عمل بخبر الواحد المتأمرون الذين يتحشم التصريح بخلافهم، وإمساك النكير عليهم لا يدل على الرضا بعملهم.
إلا ان يقال: إنه لو كان عملهم منكرا لم يترك الامام بل ولا أتباعه من الصحابة النكير على العاملين، إظهارا للحق، وإن لم يظنوا الارتداع، إذ ليست هذه المسألة بأعظم من مسألة الخلافة التي أنكرها عليهم من أنكر، لاظهار الحق ودفعا لتوهم دلالة السكوت على الرضا.
السادس: [ من وجوه تقرير الاجماع ] دعوى الاجماع من الامامية، حتى السيد وأتباعه، على وجوب الرجوع إلى هذه الاخبار الموجودة في أيدينا المودعة في أصول الشيعة وكتبهم.
ولعل هذا هو الذي فهمه بعض من عبارة الشيخ المتقدمة عن العدة، فحكم بعدم مخالفة الشيخ للسيد، قدس سرهما.
وفيه: أولا، أنه إن أريد ثبوت الاتفاق على العمل بكل واحد واحد من أخبار هذه الكتب، فهو مما علم خلافه بالعيان، وإن أريد ثبوت الاتفاق على العمل بها في الجملة على إختلاف العاملين في شروط العمل حتى يجوز أن يكون المعمول به عند بعضهم مطروحا عند آخر، فهذا لا ينفعنا إلا في حجية ما علم إتفاق الفرقة على العمل به بالخصوص.وليس يوجد ذلك في الاخبار إلا نادرا.خصوصا مع ما نرى من رد بعض المشايخ، كالصدوق والشيخ، بعض الاخبار المودعة في الكتب المعتبرة، بضعف السند أو بمخالفة الاجماع أو نحوها.
وأما ثانيا: فلان ما ذكره من الاتفاق لا ينفع، حتى في الخبر الذي علم إتفاق الفرقة على قبوله والعمل به، لان الشرط في الاتفاق العملي أن يكون وجه عمل المجمعين معلوما.
ألا ترى أنه لو
إتفق جماعة يعلم برضاء الامام، عليه السلام، بعملهم على النظر إلى إمرأة، لكن يعلم أو يحتمل أن يكون وجه نظرهم كونها زوج، لبعضهم، وأما لآخر، وبنتا لثالث، وأم زوجة لرابع، وبنت زوجة لخامس، وهكذا.
فهل يجوز لغيرهم ممن لا محرمية بينها وبينه أن ينظر إليها من جهة إتفاق الجماعة الكشاف عن رضاء الامام، عليه السلام، بل لو رأى شخص الامام، عليه السلام، ينظر إلى إمرأة، فهل يجوز لعاقل التأسي به؟ وليس هذا كله إلا من جهة أن الفعل لا دلالة فيه على الوجه الذي يقع عليه، فلا بد في الاتفاق العملي من العلم بالجهة والحيثية التي إتفق المجمعون على إيقاع الفعل من هذه الجهة و الحيثية.
ومرجع هذا إلى وجوب إحراز الموضوع في الحكم الشرعي المستفاد من الفعل.
ففيما نحن فيه إذا علم بأن بعض المجمعين يعملون بخبر من حيث علمه بصدوره بالتواتر أو بالقرينة، وبعضهم من حيث كونه ظانا بصدوره قاطعا بحجية هذا الظن، فإذا لم يحصل لنا العلم بصدوره ولا العلم بحجية الظن الحاصل منه، أو علمنا بخطأ من يعمل به لاجل مطلق الظن، أو إحتملنا خطأه، فلا يجوز لنا العمل بذلك الخبر تبعا للمجمعين.
الرابع دليل العقل وهو من وجوه، بعضها يختص بإثبات حجية خبر الواحد، وبعضها يثبت حجية الظن مطلقا أو في الجملة فيدخل فيه الخبر.
أما الاول [ وهو حجية خبر الواحد ] فتقريره من وجوه أولها: ما اعتمدته سابقا، وهو أن لا شك للمتتبع في أحوال الرواة المذكورة في تراجمهم في كون أكثر الاخبار بل جلها، إلا ما شذ وندر، صادرة عن الائمة، عليهم السلام، وهذا يظهر بعد التأمل في كيفية ورودها إلينا وكيفية إهتمال أرباب الكتب من المشايخ الثلاثة ومن تقدمهم، في تنقيح ما أودعوه في كتبهم، وعدم الاكتفاء بأخذ الرواية من كتاب وإيداعها في تصانيفهم حذرا من كون ذلك الكتاب مدسوسا فيه من بعض الكذابين.
فقد حكي عن أحمد بن محمد بن عيسى أنه قال: (جئت إلى الحسن بن علي الوشاء وسألته أن يخرج إلي كتابا لعلاء بن رزين وكتاب لابان بن عثمان الاحمر، فأخرجهما.
فقلت: أحب أن أسمعها.
فقال لي: رحمك الله، ما أعجلك اذهب، فاكتبهما وأسمع من بعد.
فقلت له: لا آمن الحدثان.
فقال: لو علمت أن الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه، فإني قد أدركت في هذا المسجد مائة شيخ، كل يقول: حدثني جعفر بن محمد، عليهما السلام).
وعن حمدويه، عن أيوب بن نوح: (أنه دفع إليه دفترا فيه أحاديث محمد بن سنان، فقال: إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا، فإني كتبت عن محمد بن سنان، ولكن لا أروي لكم عنه شيئا، فإنه قال قبل موته: كل ما حدثتكم به فليس بسماع ولا برواية، وإنما وجدته).
فانظر كيف إحتاطوا في الرواية لم يسمع من الثقات وإنما وجد في الكتب.
وكفاك شاهدا أن علي بن الحسن بن فضال لم يرو كتب أبيه الحسن عنه مع مقابلتها عليه، وإنما يرويها عن أخويه أحمد ومحمد عن أبيه.
واعتذر عن ذلك بأنه يوم مقابلته الحديث مع أبيه كان صغير السن ليس له كثر معرفة بالروايات، فقرأها على أخويه ثانيا والحاصل: أن الظاهر إنحصار مدارهم على إيداع ما سمعوه من صاحب الكتاب أو ممن سمعه منه، فلم يكونوا يودعون إلا ما سمعوا ولو بوسائط من صاحب الكتاب، ولو كان معلوم الانتساب مع إطمينانهم بالوسائط وشدة وثوقهم بهم.
حتى أنهم ربما كانوا يتبعونهم في تصحيح الحديث ورده، كما إتفق للصدوق بالنسبة إلى شيخه إبن الوليد، قدس سرهما.
وربما كانوا لا يثقون بمن يوجد فيه قدح بعيد المدخلية في الصدق.
ولذا حكي عن جماعة منهم التحرز عن الرواية عمن يروي من الضعفاء ويعتمد المراسيل، وإن كان ثقة في نفسه.
كما إتفق بالنسبة إلى البرقي.
بل يتحرزون عن الرواية عمن يعمل بالقياس، مع أن عمله لا دخل له بروايته، كما إتفق بالنسبة إلى الاسكافي، حيث ذكر في ترجمته أنه كان يرى القياس، فترك رواياته لاجل ذلك.
وكانوا يتوقفون في روايات من كان على الحق فعدل عنه، وإن كانت كتبه ورواياته حال الاستقامة، حتى أذن لهم الامام، عليه السلام، أو نائبه.
كما سألوا العسكري، عليه السلام، عن كتب بني فضال، وقالوا: إن بيوتنا منها ملاء، فأذن عليه السلام لهم.
وسألواالشيخ أبا القاسم بن روح عن كتب إبن عزاقر التي صنفها قبل الارتداد عن مذهب الشيعة، حتى أذن لهم الشيخ في العمل بها.
والحصال: أن الامارات الكاشفة عن إهتمام أصحابنا في تنقيح الاخبار في الازمنة المتأخرة
عن إ زمان الرضا، عليه السلام، أكثر من أن تحصى ويظهر للمتتبع.
* * *
والداعي إلى شدة الاهتمام - مضافا إلى كون تلك الروايات أساس الدين وبها قوام شريعة سيد المرسلين، صلى الله عليه وآله، ولهذا قال الامام، عليه السلام، في شأن جماعة من الرواة: (لولا هؤلاء لاندرست آثار النبوة)، وأن الناس لا يرضون بنقل ما لا يوثق به في كتبهم المؤلفة في التواريخ التي لا يترتب على وقوع الكذب فيها أثر ديني بل ولا دنيوي، فكيف في كتبهم المؤلفة، لرجوع من يأتي إليها في أمور الدين، على ما أخبرهم الامام، عليه السلام، بأنه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون إلا بكتبهم، وعلى ما ذكره الكليني، قدس سره، في ديباجة الكافي من كون كتابه مرجعا لجميع من يأتي بعد ذلك - ما تنبهوا له ونبههم عليه الائمة - عليهم السلام - من أن الكذابة كانوا يدسون الاخبار المكذوبة في كتب أصحاب الائمة، عليهم السلام، كما يظهر من الروايات الكثيرة: منها: أنه عرض يونس بن عبدالرحمن على سيدنا أبي الحسن الرضا، عليه السلام، كتب جماعة من أصحاب الباقر والصادق، عليهما السلام، فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبدالله عليه السلام.
وقال: (إن أبا الخطاب كذب على أبي عبدالله، عليه السلام، وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون الاحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبدالله عليه السلام).
ومنها: ما عن هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبدالله عليه السلام يقول: (كان المغيرة بن سعد، لعنه الله، يتعمد الكذب على أبي ويأخذ كتب أصحابه، وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة، لعنه الله، فكان يدس فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي، عليه السلام)، الحديث.
ورواية الفيض بن المختار المتقدمة في ذيل كلام الشيخ.
إلى غير ذلك من الروايات.
وظهر مما ذكرنا أن ما علم إجمالا من الاخبار الكثيرة من وجود الكذابين ووضع الحديث،
فهو إنما كان قبل زمان مقابلة الحديث وتدوين علمي الحديث والرجال بين أصحاب الائمة، عليهم السلام، مع أن العلم بوجود الاخبار المكذوبة إنما ينافي دعوى القطع بصدور الكل التي تنسب إلى بعض الاخباريين، أو دعوى الظن بصدور جميعها.
ولا ينافي ذلك ما نحن بصدده، من دعوى العلم الاجمالي بصدور أكثرها أو كثير منها، بل هذه دعوى بديهية.
والمقصود مما ذكرنا دفع ما ربما يكابره المتعسف الخالي عن التتبع من منع هذا العلم الاجمالي.
ثم إن هذا العلم الاجمالي إنما هو متعلق بالاخبار المخالفة للاصل المجردة عن القرينة، وإلا فالعلم بوجود مطلق الصادر لا ينفع.
فإذا ثبت العلم الاجمالي بوجود الاخبار الصادرة، فيجب بحكم العقل العمل بكل خبر مظنون الصدور، لان تحصيل الواقع الذي يجب العمل به إذا لم يمكن على وجه العلم تعين المصير إلى الظن في تعيينه، توصلا إلى العمل بالاخبار الصادرة.
* * *
بل ربما يدعى وجوب العمل بكل واحد منها مع عدم المعارض والعمل بمظنون الصدور أو بمظنون المطابقة للواقع من المتعارضين.
والجواب عنه: أولا، أن وجوب العمل بالاخبار الصادرة إنما هو لاجل وجوب إمتثال أحكام الله الواقعي المدلول عليها بتلك الاخبار.
فالعمل بالخبر الصادر عن الامام، عليه السلام، إنما يجب من حيث كشفه عن حكم الله الواقعى.
وحينئذ نقول: إن العلم الاجمالي ليس مختصا بهذه الاخبار، بل نعلم إجمالا بصدور أحكام كثيرة عن الائمة، عليهم السلام، لوجود تكاليف كثيرة، وحينئذ فاللازم أولا، الاحتياط، ومع تعذره أو تعسره أو قيام الدليل على عدم وجوبه يرجع إلى ما أفاد الظن بصدور الحكم الشرعي التكليفي عن الحجة، عليه السلام، سواء كان المفيد للظن خبرا أو شهرة أو غيرهما.
فهذا الدليل لا يفيد حجية خصوص الخبر، وإنما يفيد حجية كل ما ظن منه بصدور الحكم عن الحجة وإن لم يكن خبرا.
فإن قلت: المعلوم صدور كثير من هذه الاخبار التي بأيدينا.
وأما صدور الاحكام المخالفة للاصول غير مضمون هذه الاخبار فهو غير معلوم لنا ولا مظنون.
قلت: أولا، العلم الاجمالي وإن كان حاصلا في خصوص هذه الروايات التي بأيدينا، إلا أن العلم الاجمالي حاصل أيضا في مجموع ما بأيدينا من الاخبار ومن الامارات الاخر المجردة عن الخبر التي بأيدينا المفيدة للظن بصدور الحكم عن الامام، عليه السلام، وليست هذا الامارات خارجة عن أطراف العلم الاجمالي الحاصل في المجموع بحيث يكون العلم الاجمالي في المجموع مستندا إلى
بعضها وهي الاخبار، ولذا لو فرضنا عزل طائفة من هذه الاخبار وضممنا إلى الباقي مجموع الامارات الاخر كان العلم الاجمالي بحاله.
فهنا علم إجمالي حاصل في الاخبار وعلم إجمالي حاصل بملاحظة مجموع الاخبار وسائر الامارات المجردة عن الخبر.
فالواجب مراعاة العلم الاجمالي الثانى وعدم الاقتصار على مراعاة الاول.
نظير ذلك: ما إذا علمنا إجمالا بوجود شياه محرمة في قطيع غنم بحيث يكون نسبته إلى كل بعض منها كنسبته إلى البعض الآخر وعلمنا أيضا بوجود شياه محرمة في خصوص طائفة خاصة من تلك الغنم بحيث لو لم يكن من الغنم إلا هذه علم إجمالا بوجود الحرام فيها أيضا.
والكاشف عن ثبوت العلم الاجمالي في المجموع ما أشرنا إليه سابقا، من أنه لو عزلنا من هذه الطائفة الخاصة التي علم بوجود الحرام فيها قطعة توجب إنتفاء العلم الاجمالي فيها وضممنا إليها مكانها باقي الغنم حصل العلم الاجمالي بوجود الحرام فيها أيضا.
وحينئذ فلا بد من أن نجري حكم العلم الاجمالي في تمام الغنم إما بالاحتياط أو بالعمل بالمظنة لو بطل وجوب الاحتياط.
وما نحن فيه من هذا القبيل.
ودعوى أن سائر الامارات المجردة لا مدخل لها في العلم الاجمالي وأن هنا إجماليا واحدا بثبوت الواقع بين الاخبار، خلاف الانصاف.
وثانيا: إن اللازم من ذلك العلم الاجمالى هو العمل بالظن في مضمون تلك الاخبار، لما عرفت من أن العمل بالخبر الصادر إنما هو بإعتبار كون مضمونه حكم الله الذي يجب العمل به.
وحينئذ فكلما ظن بمضمون خبر منها ولو من جهة الشهرة يؤخذ به، وكل خبر لم يحصل الظن بكون مضمونه حكم الله لا يؤخذ به ولو كان مظنون الصدور.
فالعبرة بظن مطابقة الخبر للواقع، لا بظن الصدور.
وثالثا: إن مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالخبر المقتضي للتكليف، لانه الذي يجب العمل به.
وأما الاخبار الصادرة النافية للتكليف فلا يجب العمل بها نعم يجب الاذعان بمضمونها وإن لم تعرف بعينها.
وكذلك لا يثبت به حجية الاخبار على وجه ينهض لصرف ظواهر الكتاب والسنة القطعية.
والحاصل: أن معنى حجية الخبر كونه دليلا متبعا في مخالفة الاصول العملية والاصول اللفظية مطلقا.
وهذا المعنى لا يثبت بالدليل المذكور، كما لا يثبت بأكثر ما سيأتي من الوجوه العقلية بل كلها، فانتظر، الثاني: ما ذكره في الوافية، مستدلا على حجية الخبر الموجود في الكتب المعتمدة للشيعة، كالكتب
الاربعة، مع عمل جمع به، من غير رد ظاهر، بوجوه، قال: (الاول: أنا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة، سيما بالاصول الضرورية، كالصلاة والزكاة والصوم والحج والمتاجر والانكحة ونحوها، مع أن جل أجزائها وشرائطها وموانعها إنما يثبت بالخبر الواحد الغير القطعي، بحيث يقطع بخروج حقائق هذه الامور عن كونها هذه الامور عند ترك العمل بخبر الواحد.
ومن أنكر فإنما ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالايمان)، إنتهى.
ويرد عليه: أولا، أن العلم الاجمالي حاصل بوجود الاجزاء والشرائط بين جميع الاخبار، لا خصوص الاخبار المشروطه بما ذكره، ومجرد وجود العلم الاجمالي في تلك الطائفة الخاصة لا يوجب خروج غيرها عن أطراف العلم الاجمالي، كما عرفت في الجواب الاول عن الوجه الاول.
وإلا لما أمكن إخراج بعض هذه الطائفه الخاصة ودعوى العلم الاجمالي في الباقي، كأخبار العدول مثلا.
فاللازم حينئذ إما الاحتياط والعمل بكل خبر دل على جزئية شئ أو شرطيته، وإما العمل بكل خبر ظن صدوره مما دل على الجزئية أو الشرطية، إلا أن يقال: إن المظنون الصدور من الاخبار هو الجامع لما ذكره من الشروط.
وثانيا، أن مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالاخبار الدالة على الشرائط والاجزاء دون الاخبار الدالة على عدمهما، خصوصا إذا إقتضى الاصل الشرطية والجزئية.
الثالث: ما ذكره بعض المحققين من المعاصرين في حاشيته على المعالم لاثبات حجية الظن الحاصل من الخبر، لا مطلقا.وقد لخصناه لطوله.
وملخصه: (أن وجوب العمل بالكتاب والسنة ثابت بالاجماع، بل الضرورة والاخبار المتواترة، وبقاء هذا التكليف أيضا بالنسبة إلينا ثابت بالادلة المذكورة.
وحينئذ فإن أمكن الرجوع إليهما على وجه يحصل العلم بهما بحكم أو الظن الخاص به، فهو، وإلا فالمتبع هو الرجوع إليهما على وجه يحصل الظن منهما).
هذا حاصله.وقد أطال، قدس سره، في النقص والابرام بذكر الايرادات والاجوبة على هذا المطلب.
ويرد عليه: أن هذا الدليل بظاهره عبارة أخرى عن دليل الانسداد الذي ذكروه لحجية الظن في
الجملة أو مطلقا.وذلك لان المراد بالسنة هو قول الحجة أو فعله أو تقريره.فإذا وجب علينا الرجوع إلى مدلول الكتاب والسنة ولم نتمكن من الرجوع إلى ما علم أنه مدلول الكتاب أو السنة تعين الرجوع بإعتراف المستدل إلى ما يظن كونه مدلولا لاحدهما، فإذا ظنناأن مؤدى الشهرة أو معقد الاجماع المنقول مدلول للكتاب أو لقول الحجة أو فعله أو تقريره وجب الاخذ به.
ولا إختصاص للحجية بما يظن كونه مدلولا لاحد هذه الثلاثة من جهة حكاية أحدها التي تسمى خبرا وحديثا في الاصطلاح.
نعم يخرج عن مقتضى هذا الدليل الظن الحاصل بحكم الله من أمارة لا يظن كونها مدلولا لاحد الثلاثة.
كما إذا ظن بالاولوية العقلية أو الاستقراء أن الحكم كذا عند الله ولم يظن بصدوره عن الحجة أو قطعنا بعدم صدوره عنه عليه السلام، إذ رب حكم واقعي لم يصدر عنهم وبقي مخزونا عندهم لمصلحة من المصالح.
لكن هذا نادر جدا، للعلم العادي بأن هذه المسائل العامة البلوى قد صدر حكمها في الكتاب أو ببيان الحجة قولا أو فعلا أو تقريرا.فكل ما ظن أمارة بحكم الله تعالى، فقد ظن بصدور ذلك الحكم عنهم.
والحاصل: أن مطلق الظن بحكم الله ظن بالكتاب أو السنة، ويدل على إعتباره ما دل على إعتبار الكتاب والسنة الظنية.
فإن قلت: المراد بالسنة الاخبار والاحاديث.
والمراد أنه يجب الرجوع إلى الاخبار المحكية عنهم، فإن تمكن من الرجوع إليها على وجه يفيد العلم فهو، وإلا وجب الرجوع إليها على وجه يظن منه بالحكم.
قلت: مع أن السنة في الاصطلاح عبارة عن نفس قول الحجة أو فعله أو تقريرة، لا حكاية أحدها، يرد عليه: أن الامر بالعمل بالاخبار المحكية المفيدة للقطع بصدورها ثابت بما دل على الرجوع إلى قول الحجة، وهو الاجماع والضرورة الثابتة من الدين أو المذهب.
وأما الرجوع إلى الاخبار المحكية التي لا تفيد القطع بصدورها عن الحجة، فلم يثبت ذلك بالاجماع والضرورة من الدين التي إدعاها المستدل، فإن غاية الامر دعوى إجماع الامامية عليه في الجملة، كما إدعاه الشيخ والعلامة في مقابل السيد وأتباعه قدست أسرارهم.
وأما دعويس الضرورة من الدين والاخبار المتواترة، كما إدعاها المستدل، فليست في محلها.
ولعل هذه الدعوى قرينة على أن مراده من السنة نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره، لا حكايتها التي لا توصل إليها على وجه العلم.
نعم لو إدعى الضرورة على وجوب الرجوع إلى تلك الحكايات الغير العلمية لاجل لزوم الخروج عن الدين لو طرحت بالكلية.
يرد عليه: أنه إن أراد لزوم الخروج عن الدين من جهة العلم، بمطابقة كثير منها للتكاليف الواقعية التي يعلم بعدم جواز رفع اليد عنها عند الجهل بها تفصيلا، فهذا يرجع إلى دليل الانسداد الذي ذكروه لحجية الظن، ومفاده ليس إلا حجية كل أمارة كاشفة عن التكليف الواقعي.
وإن أرد لزومه من جهة خصوص العلم الاجمالى بصدور أكثر هذه الاخبار حتى لا يثبت به غير الخبر الظني من الظنون ليصير دليلا عقليا على حجية خصوص الخبر، فهذا الوجه يرجع إلى الوجه الاول الذي قدمناه وقدمنا الجواب عنه، فراجع.
هذا تمام الكلام في الادلة التي أقاموها على حجية الخبر، وقد علمت دلالة بعضها وعدم دلالة البعض الاخر.
والانصاف: أن الدال منها لم يدل إلا على وجوب العمل بما يفيد الوثوق والاطمينان بمؤداه، وهو الذي فسر به الصحيح في مصطلح القدماء.
والمعيار فيه أن يكون إحتمال مخالفته للواقع بعيدا بحيث لا يعتني به العقلاء ولا يكون عندهم موجبا للتحير والتردد الذي لا ينافي حصول مسمى الرجحان، كما نشاهد في الظنون الحاصلة بعد التروي في شكوك الصلاة، فافهم.
وليكن على ذكر منك، لينفعك فيما بعد.
الثاني حجية مطلق الظن فلنشرع في الادلة التي اقاموها على ججية الظن من غير خصوصية للخبر يقتضيها نفس الدليل وإن إقتضاها أمر آخر، وهو كون الخبر مطلقا أو خصوص قسم منه متيقن الثبوت من ذلك الدليل إذا فرض أنه لا يثبت إلا الظن في الجملة ولا يثبته كلية.
وهي أربعة:
الاول أن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر، ودفع الضرر المظنون لازم.
أم الصغرى، فلان الظن بالوجوب ظن بإستحقاق العقاب على الترك، كما أن الظن بالحرمة ظن بإستحقاق العقاب على الفعل، أو لان الظن بالوجوب ظن بوجود المفسدة في الترك، كما أن الظن بالحرمة ظن بالمفسدة في الفعل، بناء على قول (العدلية) بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد.وقد جعل في النهاية كلا من الضررين دليلا مستقلا على المطلب.
وأجيب عنه بوجوه: أحدهما: ما عن الحاجبي، وتبعه غيره، من منع الكبرى، وأن دفع الضرر المظنون إذا قلنا بالتحسين والتقبيح العقليين إحتياط مستحسن، لا واجب.
وهو فاسد لان الحكم المذكور حكم إلزامي أطبق العقلاء على الالتزام به في جميع أمورهم وذم من خالفه.
ولذا إستدل به المتكلمون في وجوب شكر المنعم الذي هو مبنى وجوب معرفة الله تعالى، ولولاه لم يثبت وجوب النظر في المعجزة ولم يكن لله على غير الناظر حجة.
ولذا خصوا النزاع في الحظر والاباحة في غير المستقلات العقلية بما كان مشتملا على منفعة وخاليا عن إمارة المفسدة، فإن هذا التقييد يكشف عن أن ما فيه أمارة المضرة لا نزاع في قبحه.
بل الاقوى، كما صرح به الشيخ في العدة في مسألة الاباحة والحظر، والسيد في الغنية، وجوب دفع الضررالمحتمل.
وببالي أنه تمسك في
العدة بعد العقل بقوله تعالى: (ولا تلقوا، إلخ).
ثم إن ما ذكره من إبتناء الكبرى على التحسين والتقبيح العقليين غير ظاهر، لان تحريم تعريض النفس للمهالك والمضار الدنيوية والاخروية مما دل عليه الكتاب والسنة، مثل التعليل في آية النبأ، وقوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، وقوله تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)، بناء على أن المراد العذاب والفتنة الدنيويان.
وقوله تعالى: (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة)، وقوله تعالى: (ويحذركم الله نفسه)، وقوله تعالى: (أفأمن الذين مكروا السيئات)، إلى غير ذلك.
نعم، التمسك في سند الكبرى بالادلة الشرعية يخرج الدليل المذكور عن الادلة العقلية.
لكن الظاهر ان مراد الحاجبي منع أصل الكبرى، لا مجرد إستقلال العقل بلزومه.
ولا يبعد عن الحاجبي أن يشتبه عليه حكم العقل الالزامي بغيره، بعد أن إشتبه عليه أصل حكم العقل بالحسن والقبح.
والمكابرة في الاول ليس بأعظم منها في الثاني.
ثانيها: ما يظهر من العدة والغنية وغيرهما، من أن الحكم المذكور مختص بالامور الدنيوية، فلا يجري في الاخروية مثل العقاب.
وهذا كسابقه في الضعف، فإن المعيار هو التضرر، مع أن المضار الاخروية أعظم، اللهم إلا أن يريد المجيب ما سيجئ، من أن العقاب مأمون على ما لم ينصب الشارع دليلا على التكليف به، بخلاف المضار الدنيوية التابعة لنفس الفعل أو الترك علم حرمته أو لم يعلم، أو يريد أن المضار الغير الدنيوية وإن لم تكن خصوص العقاب، مما دل العقل والنقل على وجوب إعلامها على الحكيم، وهو الباعث له على التكليف والبعثة.
لكن هذا الجواب راجع إلى منع الصغرى، لا الكبرى.
ثالثها: النقض بالامارات التي قام الدليل القطعي على عدم إعتبارها، كخبر الفاسق والقياس على مذهب الامامية.
وأجيب عنه تارة بعدم إلتزام حرمة العمل بالظن عند إنسداد باب العلم، وأخرى بأن الشارع إذا ألغى ظنا تبين أن في العمل به ضررا اعظم من ضرر ترك العمل به.
ويضعف الاول: بأن دعوى: (وجوب العمل بكل ظن في كل مسأله إنسد فيها باب العلم وإن لم ينسد في غيرها)، الظاهر أنه خلاف مذهب الشيعة، لا أقل من كونه مخالفا لاجماعاتهم المستفيضة بل المتواترة، كما يعلم مما ذكروه في القياس.
والثاني: بأن إتيان الفعل حذرا من ترتب الضرر على تركه، أو تركه حذرا من التضرر بفعله، لا يتصور فيه ضرر أصلا، لانه من الاحتياط الذي إستقل العقل بحسنه وإن كانت الامارة مما ورد النهي عن إعتباره.
نعم متابعة الامارة المفيدة للظن بذلك الضرر وجعل مؤداها حكم الشارع والالتزام به والتدين به، ربما كان ضرره أعظم من الضرر المظنون، فإن العقل مستقل بقبحه ووجود المفسدة فيه وإستحقاق العقاب عليه، لانه تشريع.
لكن هذا لا يختص بما علم إلغاؤه، بل هو جار في كل ما لم يعلم إعتباره.
توضيحه: أنا قدمنا لك في تأسيس الاصل في العمل بالمظنة: أن كل ظن لم يقم على إعتباره دليل قطعي، سواء قام دليل على إعتباره أم لا، فالعمل به، بمعنى التدين بمؤداه وجعله حكما شرعيا، تشريع محرم دل على حرمته الادلة الاربعة.
وأما العمل به - بمعنى إتيان ما ظن وجوبه مثلا أو ترك ما ظن حرمته من دون أن يتشرع بذلك - فلا قبح فيه، إذا لم يدل دليل من الاصول والقواعد المعتبرة يقينا على خلاف مؤدى هذا الظن بأن يدل على تحريم ما ظن وجوبه أو وجوب ما ظن تحريمه.
فإن أراد أن الامارات التي يقطع بعدم حجيتها، كالقياس وشبهه، يكون في العمل بها، بمعنى التدين بمؤداها وجعله حكما شرعيا، ضرر أعظم من الضرر المظنون، فلا إختصاص لهذا الضرر بتلك الظنون، لان كل ظن لم يقم على إعتباره دليل قاطع يكون في العمل به بذلك المعنى هذا الضرر العظيم أعني التشريع.
وإن أراد ثبوت الضرر في العمل بها، بمعنى إتيان ما ظن وجوبه حذرا من الوقوع في مضرة ترك الواجب، وترك ما ظن حرمته لذلك، كما يقتضيه قاعدة دفع الضرر، فلا ريب في إستقلال العقل وبداهة حكمه بعدم الضرر في ذلك أصلا وإن كان ذلك في الظن القياسي.
وحينئذ فالاولى لهذا المجيب أن يبدل دعوى الضرر في العمل بتلك الامارات المنهي عنها بالخصوص: بدعوى أن في نهي الشارع عن الاعتناء بها وترخيصه في مخالفتها، مع علمه بأن تركها ربما يفضي إلى ترك الواجب وفعل الحرام مصلحة يتدارك بها الضرر المظنون على تقدير ثبوته في الواقع، فتأمل.
وسيجئ تمام الكلام عند التكلم في الظنون المنهي عنها بالخصوص وبيان كيفية
عدم شمول أدلة حجية الظن لها إن شاء الله تعالى.
فالاولى أن يجاب عن هذا الدليل: بأنه إن اريد من الضرر المظنون العقاب، فالصغرى ممنوعة، لان إستحقاق العقاب على الفعل أو الترك كإستحقاق الثواب عليهما ليس ملازما للوجوب والتحريم الوقعيين، كيف وقد يتحقق التحريم ونقطع بعدم العقاب في الفعل، كما في الحرام والواجب المجهولين جهلا بسيطا أو مركبا، بل إستحقاق الثواب والعقاب إنما هو على تحقق الاطاعة والمعصية اللتين لا تتحققان إلا بعد العلم بالوجوب والحرمة أو الظن المعتبر بهما.
وأما الظن المشكوكالاعتبار فهو كالشك، بل هو هو، بعد ملاحظة ان من الظنون ما أمر الشارع بإلغائه، ويحتمل أن يكون المفروض منها.
اللهم إلا أن يقال: أن الحكم بعدم العقاب والثواب فيما فرض من صورتي الجهل البسيط أو المركب بالوجوب والحرمة، إنما هو لحكم العقل بقبح التكليف مع الشك أو القطع بالعدم.
وأما مع الظن بالوجوب أو التحريم، فلا يستقل العقل بقبح المؤاخذة، ولا إجماع أيضا على أصالة البراءة في موضوع النزاع.
ويرده: أنه لا يكفي المستدل منع إستقلال العقل عدم ثبوت الاجماع، بل لا بد له من إثبات أن مجرد الوجوب والتحريم الواقعيين مستلزمان للعقاب حتى يكون الظن بهما ظنا به.فإذا لم يثبت ذلك بشرع ولا عقل لم يكن العقاب مظنونا، فالصغرى غير ثابتة.ومنه يعلم فساد ما ربما يتوهم أن قاعدة دفع الضرر يكفي للدليل على ثبوت الاستحقاق.
وجه الفساد أن هذه القاعدة موقوفة على ثبوت الصغرى، وهي الظن بالعقاب.
نعم لو ادعي أن دفع الضرر المشكوك لازم، توجه فيما نحن فيه الحكم بلزوم الاحتراز في صورة الظن بناء على عدم ثبوت الدليل على نفي العقاب عند الظن، فيصير وجوده محتملا، فيجب دفعه.
لكنه رجوع عن الاعتراف بإستقلال العقل وقيام الاجماع على عدم الموأخذة على الوجوب والتحريم المشكوكين.
وإن اريد من الضرر المظنون المفسدة المظنونة، ففيه: أيضا منع الصغرى، فإنا وإن لم نقل بتغير المصالح والمفاسد بمجرد الجهل، إلا أنا لا نظن بترتب المفسدة بمجرد إرتكاب ما ظن حرمته لعدم كون فعل الحرام علة تامة لترتب المفسدة، حتى مع القطع بثبوت الحرمة، لاحتمال تداركها بمصلحة فعل آخر لا يعلمه المكلف أو يعلمه بإعلام الشارع، نظير الكفارة والتوبة وغيرهما من الحسنات اللاتي يذهبن السيئات.
ويرد عليه: أن الظن بثبوت مقتضى المفسدة مع الشك في وجود المانع كاف في وجوب الدفع، كما في صورة القطع بثبوت المقتضي مع الشك في وجود المانع، فإن إحتمال وجود المانع للضرر أو وجود ما يتدارك الضرر لا يعتني به عند العقلاء سواء جامع الظن بوجود مقتضي الضرر أم القطع به، بل أكثر موارد إلتزام العقلاء التحرز عن المضار المظنونة، كسلوك الطرق المخوفة وشرب الادوية المخوفة ونحو ذلك من موارد الظن بمقتضى الضرر دون العلة التامة له.
بل المدار - في جميع غايات حركات الانسان من المنافع المقصود جلبها والمضار المقصود دفعها - على المقتضيات دون العلل التامة، لان الموانع والمزاحمات مما لا تحصى ولا يحاط بها.
وأضعف من هذا الجواب ما يقال: إن في نهي الشارع عن العمل بالظن كلية إلا ما خرج، ترخيصا في ترك مراعاة الضرر المظنون، ولذا لا يجب مراعاته إجماعا في القياس.
ووجه الضعف ما ثبت سابقا من أن عمومات حرمة العمل بالظن أو بما عدا العلم إنما يدل على حرمته، من حيث انه لا يغنى عن الواقع ولا يدل على حرمة العمل به في مقام إحراز الواقع والاحتياط لاجله والحذر عن مخالفته.
فالاولى أن يقال: إن الضرر وإن كان مظنونا، إلا أن حكم الشارع قطعا أو ظنا بالرجوع في مورد الظن إلى البراءة والاستصحاب وترخيصه لترك مراعاة الظن أوجب القطع أو الظن بتدارك ذلك الضرر المظنون، وإلا كان ترخيص العمل على الاصل المخالف للظن إلغاء المفسدة.
توضيح ذلك: أنه لا إشكال في أنه متى ظن بوجوب شئ وأن الشارع الحكيم طلب فعله منا طلبا حتميا منجزا لا يرضى بتركه إلا أنه إختفى علينا ذلك الطلب، أو حرم علينا فعلا كذلك، فالعقل مستقل بوجوب فعل الاول وترك الثاني.
لانه يظن في ترك الاول الوقوع في مفسدة ترك الواجب المطلق الواقعي والمحبوب المنجز النفس الامري، ويظن في فعل الثاني الوقوع في مفسدة الحرام الواقعي والمبغوض النفس الامري، إلا أنه لو صرح الشارع بالرخصة في ترك العمل في هذه الصورة كشف ذلك عن مصلحة بتدارك بها ذلك الضرر المظنون.
ولذا وقع الاجماع على عدم وجوب مراعاة الظن بالوجوب أو الحرمة إذا حصل الظن من القياس، وعلى جواز مخالفة الظن في الشبهات الموضوعية حتى يستبين التحريم أو تقوم به البينة.
ثم إنه لا فرق بين أن يحصل القطعه بترخيص الشارع ترك مراعاة الظن بالضرر، كما عرفت من الظن القياسي بالوجوب والتحريم ومن حكم الشارع بجواز الارتكاب في الشبهة الموضوعيه، وبين أن يحصل الظن بترخيص الشارع في ترك مراعاة ذلك الظن، كما في الظن الذي ظن كونه منهيا
عنه عند الشارع، فإنه يجوز ترك مراعاته، لان المظنون تدارك ضرر مخالفته لاجل ترك مظنون الوجوب أو فعل مظنون الحرمة، فافهم.
إذا عرفت ذلك، فنقول: إن أصل البراءة والاستصحاب إن قام عليهما الدليل القطعي، بحيث يدل على وجوب الرجوع إليهما في صورة عدم العلم ولو مع وجود الظن الغير المعتبر، فلا إشكال في عدم وجوب مراعاة ظن الضرر، وفي أنه لا يجب الترك أو الفعل بمجرد ظن الوجوب او الحرمة، لما عرفت من أن ترخيص الشارع الحكيم للاقدام على ما فيه ظن الضرر لا يكون إلا لمصلحة يتدارك بها ذلك الضرر المظنون على تقدير الثبوت واقعا.
وإن منعنا عن قيام الدليل القطعي على الاصول، وقلنا: إن الدليل القطعي لم يثبت على إعتبار الاستصحاب، خصوصا في الاحكام الشرعية، وخصوصا مع الظن بالخلاف.
وكذلك الدليل لم يثبت على الرجوع إلى البراءه حتى مع الظن بالتكليف، لان العمدة في دليل البراءة الاجماع والعقل المختصان بصورة عدم الظن بالتكليف، فنقول: لا أقل من ثبوت بعض الاخبار الظنية على الاستصحاب والبراءة عند عدم العلم الشامل لصورة الظن، فيحصل الظن بترخيص الشارع لنا في ترك مراعاة ظن الضرر، وهذا القد يكفي في عدم الظن بالضرر.
وتوهم: (ان تلك الاخبار الظنية لا تعاض العقل المستقل بدفع الضرر المظنون)، مدفوع بأن الفرض ان الشارع لا يحكم بجواز الاقتحام في مظان الضرر إلا عن مصلحة يتدارك بها الضرر المظنون على تقدير ثبوته، فحكم الشارع ليس مخالفا للعقل.فلا وجه لاطراح الاخبار الظنية الدالة على هذا الحكم الغير المنافي لحكم العقل.ثم إن مفاد هذا الدليل هو وجوب العمل بالظن إذا طابق الاحتياط لا من حيث هو.
وحينئذ فإذا كان الظن مخالفا للاحتياط الواجب، كما في صورة الشك في المكلف به، فلا وجه للعمل بالظن حينئذ.
ودعوى الاجماع المركب وعدم القول بالفصل واضحة الفساد، ضرورة أن العمل في الصورة الاولى لم يكن بالظن من حيث هو، بل من حيث كونه إحتياطا.وهذه الحيثية نافية للعمل بالظن في الصورة الثانية.فحاصل ذلك العمل بالاحتياط كلية وعدم العلم بالظن رأسا.
الثاني أنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوخح على الراجح، وهو قبيح.
وربما يجاب عنه: بمنع قبح ترجيح المرجوح على الراجح، إذ المرجوح قد يوافق الاحتياط، فالاخذ به حسن عقلا.
وفيه: أن المرجوح المطابق للاحتياط ليس العمل به ترجيحا للمرجوح، بل هو جمع في العمل بين الراجح والمرجوح.
مثلا، إذا ظن عدم وجوب شئ وكان وجوبه مرجوحا، فحينئذ الاتيان به من باب الاحتياط ليس طرحا للراجح في العمل، لان الاتيان لا ينافي عدم الوجوب.وإن أريد الاتيان بقصد الوجوب المنافي لعدم الوجوب.
ففيه: أن الاتيان على هذا الوجه مخالف للاحتياط، فإن الاحتياط هو الاتيان لاحتمال الوجوب، لا بقصده.
وقد يجاب أيضا: بأن ذلك فرع وجوب الترجيح، بمعنى أن الامر إذا دار بين ترجيح المرجوح وترجيح الراجح، كان الاول قبيحا.وأما إذا لم يثبت وجوب الترجيح فلا مرجح للمرجوح ولا للراجح.
وفيه: أن التوقف عن ترجيح الراجح ايضا قبيح، كترجيح المرجوح فتأمل جدا فالاولى: الجواب، أولا، بالنقض بكثير من الظنون المحرمة العمل بالاجماع أو الضرورة.
وثانيا بالحل.
وتوضيحه: تسليم القبح إذا كان التكليف وغرض الشارع متعلقا بالواقع ولم يمكن الاحتياط.
فإن العقل قاطع بأن الغرض إذا تعلق بالذهاب إلى بغداد وتردد الامر بين طريقين، أحدهما مظنون الايصال، والاخر موهومه.
فترجيح الموهوم قبيح، لانه نقض للغرض.
وأما إذا لم يتعلق التكليف بالواقع أو تعلق به مع إمكان الاحتياط، فلا يجب الاخذ بالراجح، بل اللازم في الاول هو الاخذ بمقتضى البراءة وفي الثاني الاخذ بمقتضى الاحتياط.
فإثبات القبح موقوف على إبطال الرجوع إلى البراءة في موارد الظن وعدم وجوب الاحتياط فيهما.
ومعلوم أن العقل قاض حينئذ بقبح ترجيح المرجوح، بل ترك ترجيح الراجح على المرجوح فلا بد من إرجاع هذا الدليل إلى دليل الانسداد الاتي المركب من بقاء التكليف وعدم جواز الرجوع إلى البراءة وعدم لزوم الاحتياط، وغير ذلك من المقدمات التي لا يتردد الامر بين الاخذ بالراجح والاخذ بالمرجوح إلا بعد إبطالها.
الثالث: ما حكاه الاستاد عن أستاده السيد الطباطبائي، قدس سرهما من أنه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات، ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالاتيان بكل ما يحتمل الوجوب ولو موهوما، وترك ما يحتمل الحرمة كذلك.
ولكن مقتضى قاعدة نفى العسر والحرج عدم وجوب ذلك كله، لانه عسر أكيد وحرج شديد.
فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط وإنتفاء الحرج العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات والموهومات، لان الجمع على غير هذا الوجه بإخراج بعض المظنونات وإدخال بعض المشكوكات و الموهومات باطل إجماعا.
وفيه: أنه راجع إلى دليل الانسداد الاتي، إذ ما من مقدمة من مقدمات ذلك الدليل إلا و يحتاج إليها في إتمام هذا الدليل، فراجع وتأمل حتى يظهر لك حقيقة الحال.
مع أن العمل بالاحتياط في المشكوكات أيضا كالمضنونات لا يلزم منه حرج قطعا، لقلة موارد الشك المتساوي الطرفى، كما لا يخفى، فيقتصر في ترك الاحتياط على الموهومات فقط.
ودعوى: (أن كل من قال بعدم الاحتياط في الموهومات قال بعدمه أيضا في المشكوكات)، في غاية الضعف والسقوط.
الدليل الرابع هو الدليل المعروف بدليل الانسداد وهو مركب من مقدمات المقدمة الاولى: إنسداد باب العلم والظن الخاص في معظم المسائل الفقهية.
الثانية: أنه لا يجوز لنا إهمال الاحكام المشتبهة وترك التعرض لامتثالها، بنحو من أنحاء إمتثال الجاهل العاجز عن العلم التفصيلي، بأن يقتصر في الاطاعة على التكاليف القليلة المعلومة تفصيلا، أو بالظن الخاص القائم مقام العلم بنص الشارع، ونجعل أنفسنا في تلك الموارد ممن لا حكم عليه فيها كالاطفال والبهائم، أو ممن حكمه فيها الرجوع إلى أصالة العدم.
الثالثة: أنه إذا وجب التعرض لامتثالها فليس إمتثالها بالطرق الشرعيه المقررة للجاهل، من الاخذ بالاحتياط الموجب للعلم الاجمالي بالامتثال أو الاخذ في كل مسألة بالاصل المتبع شرعا في نفس تلك المسألة مع قطع النظر عن ملاحظتها منضمة إلى غيرها من المجهولات، أو الاخذ بفتوى العالم بتلك المسألة وتقليده فيها.
الرابعة: أنه إذا بطل الرجوع في الامتثال إلى الطرق الشرعية المذكورة، لعدم الوجوب في بعضها وعدم الجواز في الاخر، والمفروض عدم سقوط الامتثال بمقتضى المقدمة الثانية، فلا تعين بحكم العقل المستقل يجوز بحكم العقل الرجوع الامتثال الضنى والموافقة الضنيه للواقع ولايجوز العدول عنه إلى الموافقة الوهمية، بأن يؤخذ بالطرف المرجوح، ولا إلى الامتثال الاحتمالي والموافقة الشكية، بأن يعتمد على أحد طرفي المسألة من دون تحصيل الظن فيها أو يعتمد على ما يحتمل كونه طريقا شرعيا للامتثال من دون إفادته للظن أصلا.
فيحصل من جميع تلك المقدمات وجوب الامتثال الظنى والرجوع إلى الظن.
المقدمة الاولى: وهي إنسداد باب العلم والظن الخاص في معظم المسائل الفقهية
فهي بالنسبة إلى إنسداد باب العلم في الاغلب غير محتاجة إلى الاثبات، ضرورة قلة ما يوجب العلم التفصيلي بالمسألة على وجه لا يحتاج العمل فيها إلى إعمال أمارة غير علمية.
وأما بالنسبة إلى إنسداد باب الظن الخاص، فهي مبتنية على أن لا يثبت من الادلة المتقدمة لحجية الخبر الواحد حجية مقدار منه يفي - بضميمة الادلة العلمية وباقي الظنون الخاصة - بإثبات معظم الاحكام الشرعية بحيث لا يبقى مانع عن الرجوع في المسائل الخالية عن الخبر وأخواته من الظنون الخاصة إلى ما يقتضيه الاصل في تلك الواقعة من البراءة أو الاستصحاب أو الاحتياط أو التخيير.
فتسليم هذه المقدمة ومنعها لا يظهر إلا بعد التأمل التام وبذل الجهد في النظر فيما تقدم من أدلة حجية الخبر وأنه هل يثبت بها حجية مقدار واف من الخبر أم لا.
وهذه هي عمدة مقدمات دليل الانسداد، بل الظاهر المصرح به في كلمات بعض أن ثبوت هذه المقدمة يكفي في حجية الظن المطلق، للاجماع عليه على تقدير إنسداد باب العلم والظن الخاص.
ولذا لم يذكر صاحب المعالم وصاحب الوافية في إثبات حجية الظن الخبري غير إنسداد باب العلم.
وأما الاحتمالات الاتية في ضمن المقدمات الاتية، من الرجوع بعد إنسداد باب العلم والظن الخاص إلى شئ آخر غير الظن، فإنما هي أمور احتملها بعض المدققين من متأخري المتأخرين.
أولهم، فيما أعلم، المحقق جمال الدين الخوانساري، حيث أورد على دليل الانسداد بإحتمال الرجوع إلى البراءة وإحتمال الرجوع إلى الاحتياط.
وزاد عليها بعض من تأخر إحتمالات أخر.
المقدمة الثانية: وعي عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة على كثرتها
وترك التعرض لامتثالها بنحو من نحاء
فيدل عليه وجوه:
الاول: الاجماع القطعي على أن المرجع على تقدير إنسداد باب العلم وعدم ثبوت الدليل على حجية أخبار الآحاد بالخصوص ليس هي البراءة وإجراء أصالة العدم في كل حكم، بل لا بد من التعرض لامتثال الاحكام المجهولة بوجه ما.
وهذا الحم وإن لم يصرح به أحد من قدمائنا بل المتأخرين في هذا المقام، إلا أنه معلوم للمتتبع في طريقة الاصحاب بل علماء الاسلام طرا.
فرب مسألة غير معنونة يعلم إتفاقهم فيها من ملاحظة كلماتهم في نظائرها.
أترى أن علماءنا العاملين بالاخبار التي بأيدينا لو لم يقم عندهم دليل خاص على إعتبارها كانوا يطرحونها ويستريحون في مواردها إلى أصالة العدم، حاشا ثم حاشا.
مع أنهم كثيرا ما يذكرون أن الظن يقوم مقام العلم في الشرعيات عند تعذر العلم.
وقد حكي عن السيد في بعض كلماته الاعتراف بالعمل بالظن عند تعذر العلم، بل قد ادعي في المختلف في باب قضاء الفوائت الاجماع على ذلك.
الثاني: أن الرجوع في جميع تلك الوقائع إلى نفي الحكم مستلزم للمخالفة القطعية الكثيرة، المعبر عنها في لسان جمع من مشايخنا بالخروج عن الدين، بمعنى أن المقتصر على التدين بالمعلومات التارك للاحكام المجهولة جاعلا لها كالمعدومة يكاد يعد خارجا عن الدين، لقلة المعلومات التي أخذ بها و كثرة المجهولات التي أعرض عنها.
وهذا أمر يقطع ببطلانه كل أحد بعد الالتفات إلى كثرة المجهولات، كما يقطع ببطلان الرجوع
إلى نفي الحكم وعدم الالتزام بحكم أصلا لو فرض - والعياذ بالله - إنسداد باب العلم والظن الخاص في جميع الاحكان وإنطماس هذا المقدار القليل من الاحكام المعلومة.
فيكشف بطلان الرجوع إلى البراءة عن وجوب التعرض لامتثال تلك المجهولات ولو على غير وجه العلم والظن الخاص، لا أن يكون تعذر العلم والظن الخاص منشأ للحكم بإرتفاع التكليف بالمجهولات، كما توهمه بعض من تصدى للايراد على كل واحدة واحدة من مقدمات الانسداد.
نعم هذا إنما يستقيم في حكم واحد أو أحكام قليلة لم يوجد عليه دليل علمي أو ظني معتبر، كما هو دأب المجتهدين بعد تحصيل الادلة والامارات في أغلب الاحكام.
أما إذا صار معظم الفقه أو كله مجهولا، فلا يجوز أن يسلك فيه هذا المنهج.
والحاصل: أن طرح أكثر الاحكام الفرعية بنفسه محذور مفروغ عن بطلانه، كطرح جميع الاحكام لو فرضت مجهولة.وقد وقع ذلك تصريحا أو تلويحا في كلام جماعة من القدماء والمتأخرين.
منهم الصدوق في الفقيه، في باب الخلل الواقع في الصلاة، في ذيل أخبار سهو النبي: (فلو جاز رد هذه الاخبار الواقعة في هذا الباب لجاز رد جميع الاخبار، وفيه إبطال للدين والشريعة)، إنتهى.
ومنه السيد، قدس سره، حيث أورد على نفسه في المنع عن العمل بخبر الواحد وقال: (فإن قلت: إذا سددتم طريق العمل بأخبار الآحاد، فعلى أي شئ تعولون في الفقه كله؟ فأجاب، بما حاصله: دعوى إنفتاح باب العلم في الاحكام).
ولا يخفى: أنه لو جاز طرح الاحكام المجهولة ولم يكن شيئا منكرا، لم يكن وجه للايراد المذكور، إذ الفقه حينئذ ليس إلا عبارة عن الاحكام التي قام عليها الدليل والمرجح وكان فيه معول، ولم يكن وقع أيضا للجواب بدعوى الانفتاح الراجعة إلى دعوى عدم الحاجه إلى أخبار الآحاد.
بل المناسب حينئذ الجواب: بأن عدم المعول في أكثر المسائل لا يوجب فتح باب العمل بخبر الواحد.
والحاصل: أن ظاهر السؤال والجواب المذكورين التسالم والتصالح على أنه لو فرض الحاجة إلى اخبار الآحاد، لعدم المعول في أكثر الفقه، لزم العمل عليها وإن لم يقم عليه دليل بالخصوص، فإن
نفس الحاجة إليها هي أعظم دليل، بناء على عدم جواز طرح الاحكام.
ومن هنا ذكر السيد صدر الدين في شرح الوافية أن السيد قد إصطلح بهذا الكلام مع المتأخرين.
ومنهم الشيخ، قدس سره، في العدة حيث أنه، بعد دعوى الاجماع على حجية أخبار الآحاد، قال، ما حاصله: إنه لو إدعى أحد أن عمل الامامية بهذه الاخبار كان لاجل قرائن إنضمت إليها، كان معولا على ما يعلم من الضرورة خلافه.
ثم قال: ومن قال إني متى عدمت شيئا من القرائن حكمت بما كان يقتضيه العقل، يلزمه أن يترك أكثر الاخبار وأكثر الاحكام ولا يحكم فيها بشئ ورد الشرع به، وهذا حد يرغب أهل العلم عنه، ومن صار إليه لا يحسن مكالمته، لانه يكون معولا على ما يعلم ضرورة من الشرع خلافه)، إنتهى.
ولعمري، إنك يكفي مثل هذا الكلام من الشيخ في قطع توهم جواز الرجوع إلى البراءة عند فرض فقد العلم والظن الخاص في أكثر الاحكام.
ومنهم المحقق في المعتبر حيث قال - في مسألة خمس الغوص في رد من نفاه، مستدلا بأنه لو كان لنقل بالسنة: - قلنا: أما تواترا فممنوع، وإلا لبطل كثير من الاحكام)، إنتهى.
ومنهم العلامة في نهج المسترشدين، في مسألة إثبات عصمة الامام، حيث ذكر أنه، عليه السلام، لا بد أن يكون حافظا للاحكام.
واستدل بأن الكتاب والسنة لا يدلن على التفاصيل - إلى أن قال: - والبراءة الاصليه ترفع جميع الاحكام.
ومنهم بعض أصحابنا في رسالته المعمولة في علم الكلام المسماة بعصر المنجود، حيث استدل على عصمة الامام، عليه السلام، بأنه حافظ للشريعة، لعدم إحاطة الكتاب والسنة به - إلى أن قال: - (والقياس باطل، والبراءة الاصلية ترفع جميع الاحكام)، إنتهى.
ومنهم الفاضل المقداد في شرح الباب الحادي عشر، إلا أنه قال: (إن الرجوع إلى البراءة الاصلية يرفع أكثر الاحكام).
والظاهر أن مراد العلامة وصاحب الرسالة، قدس سرهما، من جميع الاحكام ما عدا المستنبط
من الادلة العلمية، لان كثيرا من الاحكام ضرورية لا ترفع بالاصل ولا يشك فيها حتى يحتاج إلى الامام عليه السلام.
ومنهم المحقق الخوانساري، فيما حكى عنه السيد الصدر في شرح الوافية، من أن رجح الاكتفاء في تعديل الراوي بعدل، مستدلا، بعد مفهوم آية النبأ، بأن إعتبار التعدد يوجب خلو أكثر الاحكام عن الدليل.
ومنهم صاحب الوافية، حيث تقدم عنه الاستدلال على حجية أخبار الآحاد، بأنا نقطع مع طرح أخبار الآحاد - في مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج والمتاجر والانكحة وغيرها - بخروج حقائق هذه الامور عن كونها هذه الامور.
وهذه عبارة أخرى عن الخروج عن الدين الذي عبر به جماعة من مشايخنا.
ومنهم بعض شراح الوسائل حيث استدل على حجية أخبار الآحاد بأنه لو لم يعمل بها بطل التكليف وبطلانه ظاهر.
ومنهم المحدث البحراني صاحب الحدائق - حيث ذكر في مسأله ثبوت الربا في الحنطة بالشعير خلاف الحلي في ذلك وقوله بكونهما جنسين وأن الاخبار الواردة في إتحادهما آحاد لا توجب علما ولا عملا - قال في رده: (إن الواجب عليه مع رد هذه الاخبار ونحوها من أخبار الشريعة هو الخروج عن هذا الدين إلى دين آخر)، إنتهى.
ومنهم العضدي، تبعا للحاجبي، حيث حكي عن بعضهم الاستدلال على حجية خبر الواحد بأنه لولاها لخلت أكثر الوقائع عن المدرك.ثم إنه وإن ذكر في الجواب عنه أنا نمنع الخلو عن المدرك، لان الاصل من المدارك.لكن هذا الجواب من العامة القائلين بعدم إتيان النبي، صلى الله عليه وآله، بأحكام جميع الوقائع.ولو كان المجيب من الامامية القائلين بإكمال الشريعة وبيان جميع الاحكام لم يجب بذلك.
وبالجملة، فالظاهر أن خلو أكثر الاحكام عن المدرك المستلزم للرجوع فيها إلى نفي الحكم وعدم الالتزام في معظم الفقه بحكم تكليفي كأنه أمر مفروغ البطلان.والغرض من جيمع ذلك الرد على بعض من تصدى لرد هذه المقدمه، ولم يأت بشئ عدا ما قرع سمع كل أحد من أدلة البراءة وعدم ثبوت التكليف إلا بعد البيان، ولم يتفطن بأن مجراها في
غير ما نحن فيه، فهل يرى من نفسه إجراءها ولو فرضنا، والعياذ بالله، إرتفاع العلم بجميع الاحكام.
بل نقول: لو فرضنا أن مقلدا دخل عليه وقت الصلاة ولم يعلم من الصلاة عدا ما تعلم من أبويه بظن الصحة إحتمال الفساد عنده إحتمالا ضعيفا ولم يتمكن من أزيد من ذلك، فهل يلتزم بسقوط التكليف عنه بالصلاة في هذه الحالة، أو أنه ياتي بها على حسب ظنه الحاصل من قول أبويه، والمفروض أن قول أبويه مما لم يدل عليه دليل شرعي.
فإذا لم تجد من نفسك الرخصة في تجويز ترك الصلاة لهذا الشخص، فكيف ترخص الجاهل بمعظم الاحكام في نفي الالتزام بشئ منها، عدا القليل المعلوم أو المظنون بالظن الخاص وترك ما عداه ولو كان مظنونا بظن لم يقم على إعتباره دليل خاص.
بل الانصاف: أنه لو فرض، والعياذ بالله، فقد الظن المطلق في معظم الاحكام، كان الواجب الرجوع إلى الامتثال الاحتمالي بالتزام ما لا يقطع معه بطرح الاحكام الواقعية.
الثالث: أنه لو سلمنا أن الرجوع إلى البراءة لا يوجب شيئا مما ذكر من المحذور البديهي، وهو الخروج عن الدين، فنقول: إنه لا دليل على الرجوع إلى البراءة من جهة العلم الاجمالي بوجود الواجبات والمحرمات، فإن أدلتها مختصة بغير هذه الصورة، ونحن نعلم إجمالا أن في المظنونات واجبات كثيرة ومحرمات كثيرة.
والفرق بين هذا الوجه وسابقه: أن الوجه السابق كان مبنيا على لزوم المخالفة القطعية الكثيرة المعبر عنها بالخروج عن الدين وهو محذور مستقل، وإن قلنا بجواز العمل بالاصل في صورة لزوم مطلق المخالفة القطعية.
وهذا الوجه مبني على أن مطلق المخالفة القطعية غير جائز، وأصل البراءة في مقابلها غير جار ما لم يصل المعلوم الاجمالي إلى حد الشبهة الغير المحصورة، وقد ثبت في مسألة البراءة أن مجراها الشك في اصل التكليف، لا الشك في تعيينه مع القطع بثبوت أصله، كما في ما نحن فيه.
فإن قلت: إذا فرضنا أن ظن المجتهد أدى في جميع الوقائع إلى ما يوافق البراءة، فما تصنع؟ قلت: أولا، إنه مستحيل، لان العلم الاجمالي بوجود الواجبات والمحرمات الكثيرة في جملة الوقائع المشتبهة يمنع عن حصول الظن بعدم وجوب شي ء من الوقائع المحتملة للوجوب وعدم حرمة شئ من الوقائع المحتملة للتحريم، لان الظن بالسالبة الكلية يناقض العلم بالموجبة الجزئية، فالظن بأنه لا شخص من العلماء بفاسق، يناقض العلم إجمالا بأن بعض العلماء فاسق.
وثانيا، إنه على تقدير الامكان غير واقع، لان الاماراتالتي يحصل للمجتهد منها الظن في الوقائع لا تخلو عن الاخبار المتضمن كثير منها لاثبات التكليف وجوبا وتحريما.
فحصول الظن بعدم التكليف في جميع الوقائع أمر يعلم عادة بعدم وقوعه.
وثالثا، لو سلمنا وقوعه، لكن لا يجوز حنيئذ العمل بعدم التكليف في جميع الوقائع لاجل العلم الاجمالي المفروض، فلا بد حينئذ من التبعيض بين مراتب الظن بالقوة والضعف، فيعمل في موارد الظن الضعيف بنفي التكليف بمقتضى الاحتياط وفي موارد الظن القوى بنفي التكليف بمتقضى البراءة.
ولو فرض التسوية في القوة والضعف كان الحكم كما لو لم يكن ظن في شئ من تلك الوقائع من التخيير إن لم يتيسر لهذا الشخص الاحتياط، وإن تيسر الاحتياط تعين الاحتياط في حق نفسه وإن لم يجز لغيره تقليده، ولكن الظاهر أن ذلك مجرد فرض غير واقع، لان الامارات كثير منها مثبتة للتكليف، فراجع كتب الاخبار.
ثم إنه قد يرد الرجوع إلى أصالة البراءة تبعا لصاحب المعالم وشيخنا البهائي في الزبدة بأن إعتبارها من باب الظن، والظن منتف في مقابل الخبر ونحوه من أمارات الظن.
وفيه: منع كون البراءة من باب الظن.كيف؟ ولو كانت كذلك لم يكن دليل على إعتبارها، بل هو من باب حكم العقل القطعي بقبح التكليف من دون بيان.
وذكر المحقق القمي، رحمه الله، في منع حكم العقل المذكور: (أن حكم العقل إما أن يريد به الحكم القطعي أو الظني.
فإن كان الاول، فدعوى كون مقتضى أصل البراءة قطعيا أول الكلام، كما لا يخفى على من لاحظ أدلة المثبتين والنافين من العقل والنقل.سلمنا كونه قطعيا في الجمله، لكن المسلم إنما هو قبل ورود الشرع.
وأما بعد ورود الشرع، فالعلم بأن فيه أحكاما إجمالية على سبيل اليقين يثبطنا عن الحكم بالعدم قطعا، كما لا يخفى.
سلمنا ذلك، ولكن لا نسلم حصول القطع بعد ورود مثل الخبر الواحد الصحيح على خلافه.
وإن اراد الحكم الظني، سواء كان بسبب كونه بذاته مفيدا للظن أو من جهة إستصحاب الحالة السابقة، فهو أيضا ظن مستفاد من ظاهر الكتاب والاخبار التي لم يثبت حجيتها بالخصوص، مع أنه ممنوع بعد ورود الشرع، ثم بعد ورود الخبر
الصحيح، إذا حصل من خبر الواحد ظن أقوى منه)، إنتهى كلامه، رفع مقامه.
وفيه: أن حكم العقل بقبح المواخذة من دون البيان حكم قطعي، لا إختصاص له بحال دون حال.
فلا وجه لتخصيصه بما قبل ورود الشرع، ولم يقع فيه خلاف بين العقلاء، وإنما ذهب من ذهب إلى وجوب الاحتياط لزعم نصب الشارع البيان على وجوب الاحتياط من الآيات والاخبار التي ذكروها.
وأما الخبر الصحيح فهو كغيره من الظنون إن قام دليل قطعي على إعتباره كان داخلا في البيان، ولا كلام في عدم جريان البراءة معه، وإلا فوجوده كعدمه غير مؤثر في الحكم العقلي.
والحاصل: أنه لا ريب لاحد، فضلا عن أنه لا خلاف، في أنه على تقدير عدم بيان التكليف بالدليل العام أو الخاص، فالاصل البراءة.وحينئذ فاللازم إقامة الدليل على كون الظن المقابل بيانا.
وبما ذكرنا ظهر صحة دعوى الاجماع على أصالة البراءة في المقام، لانه إذا فرض عدم الدليل على إعتبار الظن المقابل صدق قطعا عدم البيان، فتجري البراءة.
وظهر فساد دفع أصل البراءة بأن المستند فيها إن كان هو الاجماع فهو مفقود في محل البحث، وإن كان هو العقل فمورده صورة عدم الدليل ولا نسلم عدم الدليل مع وجود الخبر.
وهذا الكلام، خصوصا الفقرة الاخيرة منه، مما يضحك الثكلى، فإن عدم ثبوت كون الخبر دليلا يكفي في تحقق مصداق القطع بعدم الدليل الذي هو مجرى البراءة.
واعلم: أن الاعتراض على مقدمات دليل الانسداد بعدم إستلزامها للعمل بالظن لجواز الرجوع إلى البراءه، وإن كان قد أشار إليه صاحب المعالم وصاحب الزبدة وأجابا عنه بما تقدم مع رده، من أن أصالة البراءة لا يقاوم الظن الحاصل من خبر الواحد، إلا أن أول من شيد الاعتراض به وحرره، لا من باب الظن، هو المحقق المدقق جمال الدين، قدس سره، في حاشيته، حيث قال: (يرد على الدليل المذكور أن إنسداد باب العلم بالاحكام الشرعية غالبا لا يوجب جواز العمل بالظن حتى يتجه ما ذكروه، لجواز أن لا يجوز العمل بالظن.
فكل حكم حصل العلم به من ضرورة أو إجماع نحكم به، وما لم يحصل العلم به نحكم فيه بأصالة البراءة، لا لكونها مفيدة للظن، ولا للاجماع على وجوب التمسك بها، بل لان العقل يحكم بأنه لا يثبت تكليف علينا إلا بالعلم به، أو بظن يقوم
على إعتباره دليل يفيد العلم.
ففيما إنتفى الامران فيه يحكم العقل ببراءة الذمة عنه وعدم جواز العقاب على تركه، لا لان الاصل المذكور يفيد ظنا بمقتضاها حتى يعارض بالظن الحاصل من أخبار الاحاد بخلافها، بل لما ذكرنا من حكم العقل بعدم لزوم شئ علينا ما لم يحصل العلم لنا ولا يكفي الظن به.
ويؤكده ما ورد من النهي عن إتباع الظن.
وعلى هذا ففي ما لم يحصل العلم به على أحد الوجهين وكان لنا مندوحة عنه كغسل الجمعة فالخطب سهل، إذ نحكم بجواز تركه بمقتضى الاصل المذكور.
وأما فيما لم يكن مندوحة عنه، كالجهر بالتسمية والاخفات بها في الصلاة الاخفاتية التى قال بوجوب كل منهما قوم ولا يمكن لنا ترك التسمية، فلا محيص لنا عن الاتيان بأحدهما، فنحكم بالتخيير فيها، لثبوت وجوب أصل التسمية وعدم ثبوت وجوب الجهر والاخفات، فلا حرج لنا في شئ منهما، وعلى هذا فلا يتم الدليل المذكور، لانا لا نعمل بالظن أصلا)، إنتهى كلامه، رفع مقامه.
وقد عرفت أن المحقق القمي، قدس سره، أجاب عنه بما لا يسلم عن الفساد، فالحق رده بالوجوه الثلاثة المتقدمة.
ثم إن ما ذكره من التخلص عن العمل بالظن بالرجوع إلى البراءة لا يجرى في جميع الفقه، إذ قد يتردد الامر بين كون المال لاحد شخصين.
كما إذا شك في صحة بيع المعاطاة فتبايع بها إثنان، فإنه لا مجرى هنا للبراءة، لحرمة تصرف كل منهما على تقدير كون المبيع ملك صاحبه، وكذا في الثمن، ولا معنى للتخيير أيضا، لان كلا منهما يختار مصلحته، وتخيير الحاكم هنا لا دليل عليه، مع أن الكلام في حكم الواقعة، لا في علاج الخصومة، اللهم إلا أن يتمسك في أمثاله بأصالة عدم ترتب الاثر، بناء على أن أصالة العدم من الادلة الشرعية.
فلو أبدل في الايراد أصالة البراءة بأصالة العدم كان أشمل.
ويمكن أن يكون هذا الاصل - يعني أصل الفساد وعدم التملك وأمثاله - داخلا في المستثنى، في قوله: (لا يثبت تكليف علينا إلا بالعلم أو بظن يقوم على إعتباره دليل يفيد العلم)، بناء على أن
أصل العدم من الظنون الخاصة التي قام على إعتبارها الاجماع والسيرة، إلا أن يمنع قيامهما على إعتباره عند إشتباه الحكم الشرعي مع وجود الظن على خلافه.
وإعتباره من باب الاستصحاب مع إبتنائه على حجية الاستصحاب في الحكم الشرعي رجوع إلى الظن العقلي أو الظن الحاصل من أخبار الآحاد الدالة على الاستصحاب.
الله إلا أن يدعى تواترها ولو إجمالا، بمعنى حصول العلم بصدور بعضها إجمالا، فيخرج عن خبر الآحاد، ولا يخلو عن تأمل.
وكيف كان ففي الاجوبة المتقدمة ولا أقل من الوجه الاخير غنى وكفاية إن شاء الله تعالى.
المقدمة الثالثة: في بيان بطلان وجوب تحصيل الامتثال
بالطرق المقررة للجاهل من الاحتياط
أو الرجوع في كل مسألة إلى ما يقتضيه الاصل في تلك المسألة أو الرجوع إلى فتوى العالم بالمسأله وتقليده فيها فنقول: إن كلا من هذه الامور الثلاثة وإن كان طريقا شرعيا في الجملة لامتثال الحكم المجهول، إلا أن منها ما لا يجب في المقام ومنها ما لا يجري.
أما الاحتياط، فهو وإن كان مقتضى الاصل والقاعدة العقلية والنقلية عند ثبوت العلم الاجمالي بوجود الواجبات والمحرمات، إلا أنه في المقام - أعني صورة إنسداد باب العلم في معظم المسائل الفقهية - غير واجب لوجهين: أحدهما: الاجماع القطعي على عدم وجوبه في المقام، لا بمعنى أن أحدا من العلماء لم يلتزم بالاحتياط في كل الفقه أو جله، حتى يرد عليه: أن عدم إلتزامهم به إنما هو لوجود المدارك المعتبرة عندهم للاحكام، فلا يقاس عليهم من لا يجد مدركا في المسألة، بل بالمعنى الذي تقدم نظيره في الاجماع على عدم الرجوع إلى البراءة.
وحاصله: دعوى الاجماع القطعي على المرجع في الشريعة - على تقدير إنسداد باب العلم في معظم الاحكام وعدم ثبوت حجية أخبار الآحاد رأسا أو بإستثناء قليل هو في جنب الباقي كالمعدوم - ليس هو الاحتياط في الدين والالتزام بفعل كل ما يحتمل الوجوب ولو موهوما، وترك كل ما يحتمل الحرمة كذلك.
وصدق هذا الدعوى مما يجده المنصف من نفسه بعد ملاحظة قلة الملومات، مضافا إلى ما يستفاد من أكثر كلمات العلماء المتقدمة في بطلان الرجوع إلى البراءة وعدم التكليف في المحهولات، فإنها واضحة الدلالة في أن بطلان الاحتياط كالبراءة مفروغ عنه، فراجع.
الثاني: لزوم العسر الشديد والحرج الاكيد في إلتزامه، لكثرة ما يحتمل موهوما وجوبه، خصوصا في أبواب الطهارة والصلاة.فمراعاته مما يوجب الحرج، والمثال لا يحتاج إليه.
فلو بنى العالم الخبير بموارد الاحتياط - فيما لم ينعقد عليه إجماع قطعي أو خبر متواتر - على الالتزام بالاحتياط في جميع أموره يوما وليلة، لوجد صدق ما ادعيناه.
هذا كله بالنسبة إلى نفس العمل بالاحتياط.
وأما تعليم المجتهد موارد الاحتياط لمقلده، وتعلم المقلد موارد الاحتياط الشخصية وعلاج تعارض الاحتياطات وترجيح الاحتياط الناشي عن الاحتمال القوي على الاحتياط الناشي عن الاحتمال الضعيف، فهو أمر مستغرق لاوقات المجتهد والمقلد، فيقع الناس من جهة تعليم هذه الموارد وتعلمها في حرج يحل بنظام معاشهم ومعادهم.
توضيح ذلك: أن الاحتياط في مسألة التطهير بالماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر ترك التطهير به، لكن قد يعارضه في الموارد الشخصية إحتياطات أخر، بعضها اقوى منه وبعضها أضعف وبعضها مساو، فإنه قد يوجد ماء آخر للطهارة، وقد لا يوجد معه إلا التراب، وقد لا يوجد من مطلق الطهور غيره.
فإن الاحتياط في الاول هو الطهارة من ماء آخر لو لم يزاحمه الاحتياط من جهة أخرى كما إذا كان قد أصابه ما لم ينعقد الاجماع على طهارته، وفي الثاني هو الجميع بين الطهارة المائية والترابية إن لم يزاحمه ضيق الوقت المجمع عليه، وفي الثالث الطهارة من ذلك المستعمل والصلاة إن لم يزاحمه أمر آخر واجب أو محتمل الوجوب.
فكيف يسوغ للمجتهد أن يلقي إلى مقلده أن الاحتياط في ترك الطهارة بالماء المستعمل مع كون الاحتياط في كثير من الموارد إستعماله فقط أو الجمع بينه وبين غيره.وبالجملة.فتعليم موارد الاحتياط الشخصية وتعلمها، فضلا عن العمل بها، أمر يكاد يلحق بالمتعذر، ويظهر ذلك بالتأمل في الوقائع الاتفاقية.
فإن قلت: لا يجب على المقلد متابعة هذا الشخص الذي أدى نظره إلى إنسداد باب العلم في معظم المسائل ووجوب الاحتياط، بل يقلد غيره.
قلت، مع أن لنا أن نفرض انحصار المجتهد في هذا الشخص: إن كلامنا في حكم الله سبحانه بحسب إعتقاد هذا المجتهد الذي اعتقد إنسداد باب العلم، وعدم الدليل على ظن خاص يكتفى به في تحصيل غالب الاحكام، وإن من يدعي وجود الدليل على ذلك فإنما نشأ إعتقاده مما ينبغي الركون إليه، ويكون الركون إليه جازما في غير محله.
فالكلام في أن حكم الله تعالى على تقدير إنسداد باب العلم وعدم نصب الطريق الخاص لا يمكن أن يكون هو الاحتياط بالنسبة إلى العباد، للزوم الحرج البالغ حد إختلال النظام.
ولا يخفى أنه لا وجه لدفع هذا الكلام بأن العوام يقلدون مجتهدا غير هذا، قائلا بعدم إنسداد باب العلم أو بنصب الطرق الظنية الوافية بأغلب الاحكام، فلا يلزم عليهم حرج وضيق.
ثم إن هذا كله، مع كون المسألة في نفسها مما يمكن فيه الاحتياط ولو بتكرار العمل في العبادات.
أما مع عدم إمكان الاحتياط - كما لو دار المال بين صغيرين يحتاج كل واحد منهما إلى صرفه عليه في الحال، وكما في المرافعات - في مناص عن العمل بالظن.
* * *
وقد يورد على إبطال الاحتياط بلزوم الحرج بوجوه لا بأس بالاشارة إلى بعضها: منها: النقض بما لو أدى إجتهاد المجتهد وعمله بالظن إلى فتوى يوجب الحرج، كوجوب الترتيب بين الحاضره والفائتة لمن عليه فوائت كثيرة، أو وجوب الغسل على مريض أجنب متعمدا وإن أصابه من المرض ما أصابه، كما هو قول بعض أصحابنا.
وكذا لو فرضنا أداء ظن المجتهد إلى وجوب امور كثيرة يحصل العسر لمراعاتها.وبالجملة فلزوم الحرج من العمل بالقواعد لا يوجب الاعراض عنها.وفيما نحن فيه إذا إقتضى القاعدة رعاية الاحتياط لم يرفع اليد عنها، للزوم العسر.
والجواب: أن ما ذكر في غاية الفساد.
لان مرجعه إن كان منع نهوض أدلة نفي الحرج للحكومة على مقتضيات القواعد والعمومات وتخصيصها بغير صورة لزوم الحرج، فينبغي أن ينقل الكلام في منع ثبوت قاعدة الحرج.ولا يخفى أن منعه في غاية السقوط، لدلالة الاخبار المتواترة معنى عليه، مضافا إلى دلالة ظاهر الكتاب.
والحاصل: أن قاعدة نفي الحرج مما ثبتت بالادلة الثلاثة بل الاربعة في مثل مقام، لاستقلال العقل بقبح التكليف بما يوجب إختلال نظام أمر الملكف، نعم هي في غير ما يوجب الاختلال قاعدة ظنية تقبل الخروج عنها بالادلة الخاصة المحكمة وإن لم تكن قطعية.
وأما القواعد والعمومات المثبتة للتكليف فلا إشكال بل لا خلاف في حكومة أدلة نفي الحرج عليها.
فليس الوجه في التقديم كون النسبة بينهما عموما من وجه، فيرجع إلى أصالة البراءة، كما قيل، أو إلى المرجحات الخارجية المعاضدة لقاعدة نفي الحرج، كما زعم، بل لان أدلة نفي العسر بمدلوها اللفظي حاكمة على العمومات المثبتة للتكليف، فهي بالذات مقدمة عليها.وهذا هو السر
في عدم ملاحظة الفقهاء المرجح الخارجي، بل يقدمونها من غير مرجح خارجي نعم جعل بعض متأخري المتأخرين عمل الفقهاء بها في الموارد من المرجحات لتلك القاعدة، زعما منه أن عملهم لمرجح توقيفي إطلعوا عليه واختفى علينا.ولم يشعر أن وجه التقديم كونها حاكمة على العمومات.
ومما يوضح ما ذكرنا - ويدعو إلى التأمل في وجه التقديم المذكور في محله، ويوجب الاعراض عما زعمه غير واحد من وقوع التعارض بينها وبين سائل العمومات فيجب الرجوع إلى الاصول أو المرجحات - هو ما رواه عبدالاعلى، مولى آل سام، في: من عثر، فانقطع ظفره، فجعل عليه مرارة، فكيف يصنع بالوضوء؟ فقال عليه السلام: (يعرف هذا وأشبهاهه من كتاب الله: ما جعل عليكم في الدين من حرج.
إمسح عليه).
فإن في إحالة الامام، عليه السلام، لحكم هذه الواقعة إلى عموم نفي الحرج - وبيان أنه ينبغي أن يعلم منه أن الحكم في هذه الواقعة المسح فوق المرارة، مع معارضة العموم المذكور بالعمومات الموجبة للمسح على البشرة - دلالة واضحة على حكومة عمومات نفي الحرج بأنفسها على العمومات المثبتة للتكاليف من غير حاجة إلى ملاحظة تعارض وترجيح في البين، فافهم.وإن كان مرجع ما ذكره إلى أن إلتزام العسر إذا دل عليه الدليل لا بأس به.
كما في ما ذكر من المثال والفرض.
ففيه: ما عرفت، من أنه لا يخصص تلك العمومات إلا ما يكون أخص منها معاضدا بما يوجب قوتها على تلك العمومات الكثيرة الواردة في الكتاب والسنة.
والمفروض أنه ليس في المقام إلا قاعدة الاحتياط التي قد رفع اليد لاجل العسر في موارد كثيرة: مثل الشبهة الغير المحصورة، وما لو علم أن عليه فوائت لا يحصى عددها، وغير ذلك.
بل أدلة نفي العسر بالنسبة إلى قاعدة الاحتياط من قبيل الدليل بالنسبة إلى الاصل.
فتقديمها عليها أوضح من تقديمها على العمومات الاجتهادية.
وأما ما ذكره - من فرض أداء ظن المجتهد إلى وجوب بعض ما يوجب العسر كالترتيب في الفوائت أو الغسل في المثالين - فظهر مما ذكرنا، من أن قاعدة نفي العسر في غير مورد الاختلال قابلة للتخصيص.
وأما ما ذكره من فرض أداء ظن المجتهد إلى وجوب امور يلزم من فعلها الحرج.
فيرد عليه:
أولا، منع إمكانه، لانا علمنا بأدلة نفي الحرج أن الواجبات الشرعية في الواقع ليست بحيث يوجب العسر على المكلف.ومع هذا العلم الاجمالي يمتنع الظن التفصيلي بوجوب أمور في الشريعة يوجب إرتكابها العسر، على مر نظيره في الايراد على دفع الرجوع إلى البراءة.
وثانيا، سلمنا إمكان ذلك، إما لكون الظنون الحاصلة في السائل الفرعية كلها او بعضها ظنونا نوعية لا تنافي العلم الاجمالي بمخالفة البعض للواقع، أو بناء على أن المستفاد من أدلة نفي العسر ليس هو القطع ولا الظن الشخصي بانتفاء العسر، بل غايته الظن النوعي الحاصل من العمومات بذلك، فلا ينافي الظن الشخصي الفصيلي في المسائل الفرعية على الخلاف، وإما بناء على ما ربما يدعى من عدم التنافي بين الظنون التفصيلية الشخصية والعمل الاجمالي بخلافها.
كما في الظن الحاصل من الغلبة مع العلم الاجمالي بوجود الفرد النادر على الخلاف.
لكن نمنع وقوع ذلك، لان الظنون الحاصلة للمجتهد، بناء على مذهب الامامية من عدم إعتبار الظن القياسي وأشبهاهه، ظنون حاصلة من أمارات مضبوطة محصورة، كأقسام الخبر والشهرة والاستقراء والاجماع المنقول والاولوية الاعتبارية ونظائرها.
ومن المعلوم للمتتبع فيها أن مؤدياتها لا تفضي إلى الحرج، لكثرة ما يخالف الاحتياط فيها، كما لا يخفى على من لاحظها وسبرها سبرا إجماليا.
وثالثا، سلمنا إمكانه ووقوعه، لكن العمل بتلك الظنون لا يؤدي إلى إختلال النظام، حتى لا يمكن إخراجها من عمومات نفي العسر، فنعمل بها في مقابلة عمومات نفي العسر ونخصصها بها، لما عرفت من قبولها التخصيص في غير مورد الاختلال.وليس هذا كرا على ما فر منه، حيث أنا عملنا بالظن فرارا عن لزوم العسر.
فإذا أدى إليه فلا وجه للعمل به، لان العسر اللازم على تقدير طرح العمل بالظن كان بالغا حد إختلال النظام من جهة لزوم مراعاة الاحتمالات الموهومة والمشكوكة.
وأما الظنون المطابقة لمقتضى الاحتياط، فلا بد من العمل بها، سواء عملنا بالظن أم عملنا بالاحتياط.
وحينئذ ليس العسر اللازم من العمل بالظنون الاجتهادية في فرض المعترض من جهة العمل بالظن، بل من جهة مطابقته لمقتضى الاحتياط.
فلو عمل بالاحتياط وجب عليه أن يضيف إلى تلك الظنون الاحتمالات الموهومة والمشكوكة المطابقة للاحتياط.
ومنها: أنه يقع التعارض بين الادلة الدالة على حرمة العمل بالظن والعمومات النافية للحرج.
والاول أكثر، فيبقى أصالة الاحتياط مع العلم الاجمالي بالتكاليف الكثيرة سليمة عن المزاحم.
وفيه: ما لا يخفى، لما عرفت في تأسيس الاصل، من أن العمل بالظن ليس فيه إذا لم يكن بقصد التشريع والالتزام شرعا بمؤداه حرمة ذاتية.وإنما يحرم إذا أدى إلى مخالفة الواقع من وجوب أو تحريم.
فالنافي للعمل بالظن فيما نحن فيه ليس إلا قاعدة الاحتياط الآمرة بإحراز الاحتمالات الموهومة وترك العمل بالظنون المقابلة لتلك الاحتمالات، وقد فرضنا أن قاعدة الاحتياط ساقطة بأدلة نفي العسر.
ثم لو فرضنا ثبوت الحرمة الذاتية للعمل بالظن ولو لم يكن على جهة التشريع، لكن عرفت سابقا عدم معارضة عمومات نفي العسر بشئ من العمومات المثبتة للتكليف المتعسر.
ومنها: أن الادلة النافية للعسر إنما تنفي وجوده في الشريعة بحسب أصل الشرع اولا وبالذات، في تنافي وقوعه بسبب عارض لا يسند إلى الشارع، ولذا لو نذر المكلف أمورا عسرة، كالاخذ بالاحتياط في جميع الاحكام الغير المعلومة، وكصوم الدهر أو إحياء بعض الليالي أو المشي إلى الحج أو الزيارات، لم يمنع تعسرها عن إنعقاد نذرها، لان الالتزام بها إنما جاء من قبل المكلف، وكذا لو آجر نفسه لعمل شاق لم يمنع مشقته من صحة الاجارة ووجوب الوفاء بها.
وحينئذ فنقول: لا ريب أن وجوب الاحتياط بإتيان كل ما يحتمل الوجوب وترك كل ما يحتمل الحرمة، إنما هو من جهة إختفاء الاحكام الشرعية المسبب عن الكلفين المقصرين في محافظة الآثار الصادرة عن الشارع المبينة للاحكام والمميزة للحلال عن الحرام.
وهذا السبب وإن لم يكن عن فعل كل مكلف لعدم مدخلية أكثر المكلفين في ذلك، إلا أن التكليف بالعسر ليس قبيحا عقليا حتى يقبح أن يكلف به من لم يكن سببا له ويختص عدم قبحه بمن صار التعسر من سوء إختياره، بل هو أمر منفي بالادلة الشرعية السمعية.
وظاهرها أن المنفي هو جعل الاحكام الشرعية أولا وبالذات على وجه يوجب العسر على المكلف، فلا ينافي عروض التعسر لامتثالها من جهة تقصير المقصرين في ضبطها وحفظها عن الاختفاء مع كون ثواب الامتثال حينئذ أكثر بمراتب.
ألا ترى أن الاجتهاد الواجب على المكلفين، ولو كفاية، من الامور الشاقة جدا، خصوصا في هذه الازمنة.
فهل السبب فيه إلا تقصير المقصرين الموجبين لاختفاء آثار الشريعة، وهل يفرق في نفي العسر بين الوجوب الكفائي والعيني.
والجواب: عن هذا الوجه أن أدلة نفي العسر، سيما البالغ منه حد إختلال النظام والاضرار بأمور المعاش والمعاد، لا فرق فيها بين ما يكون بسبب يسند عرفا إلى الشارع.
وهو الذي أريد بقولهم عليهم السلام: (ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر)، وبين ما يكون مسندا إلى غيره.
ووجوب
صوم الدهر على ناذره إذا كان فيه مشقة لا يتحمل عادة ممنوع.وكذا أمثالها من المشي إلى بيت الله جل ذكره، وإحياء الليالي، وغيرهما.
مع إمكان أن يقال بأن ما ألزمه المكلف على نفسه من المشاق خارج عن العمومات، لا ما كان السبب فيه نفس المكلف.
فيفرق بين الجنابة متعمدا فلا يجب الغسل مع المشقة، وبين إجارة النفس للمشاق، لان الحم في الاول تأسيس من الشارع وفي الثاني إمضاء لما ألزمه المكلف على نفسه.
فتأمل.
وأما الاجتهاد الواجب كفاية عند إنسداد باب العلم، فمع أنه شئ يقضي بوجوبه الادلة القطعية، فلا ينظر إلى تعسره وتيسره.فهو ليس أمرا حرجا، خصوصا بالنسبة إلى أهله، فإن مزاولة العلوم لاهلها ليس بأشق من أكثر المشاغل الصعبة التي يتحملها الناس لمعاشهم.وكيف كان فلا يقاس عليه.
وأما عمل العباد بالاحتياط ومراقبة ما هو أحوط الامرين أو الامور في الوقائع الشخصية إذا دار الامر فيها بين الاحتياطات التمعارضة، فإن هذا دونه خرط القتاد، إذ أوقات المجتهد لا تفي بتميز موارد الاحتياطات، ثم إرشاد المقلدين إلى ترجيح بعض الاحتياطات على بعض، عند تعارضها في الموارد الشخصية التي تتفق للمقلدين.
كما مثلنا لك سابقا في الماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر.
وقد يرد الاحتياط بوجوه أخر غير ما ذكرنا من الاجماع والحرج منها: أنه لا دليل على وجوب الاحتياط وأن الاحتياط أمر مستحب إذا لم يوجب إلغاء الحقوق الواجبة.
وفيه: أنه إن أريد أنه لا دليل على وجوبه في كل واقعة إذا لوحظت مع قطع النظر عن العلم الاجمالي بوجود التكليف بينها وبين الوقائع الاخر فهم مسلم، بمعنى أن كل واقعة ليست مما يقتضي الجهل فيها بنفسها الاحتياط بل الشك فيها، إن رجع إلى التكليف، - كما في شرب التتن و وجوب الدعاء عند رؤية الهلال - لم يجب فيها الاحتياط، وإن رجع إلى تعيين المكلف به، كالشك في القصر والاتمام والظهر والجمعة، وكالشك في مدخلية شئ في العبادات، بناء على وجوب الاحتياط فيما شك في مدخليته وجب فيها الاحتياط، لكن وجوب الاحتياط في ما نحن فيه في الوقائع المجهولة من جهة العلم الاجمالي بوجود الواجبات والمحرمات فيها، وإن كان الشك في نفس الواقعة شكا في التكليف.
ولذا ذكرنا سابقا أن الاحتياط هو مقتضى القاعدة الاولية عند إنسداد باب العلم.
نعم من لا يوجب الاحتياط حتى مع العلم الاجمالي بالتكليف فهو يستريح عن كلفة الجواب عن الاحتياط.
ومنها: أن العمل بالاحتياط مخالف للاحتياط، لان مذهب جماعة من العلماء بل المشهور بينهم إعتبار معرفة الوجه بمعنى تمييز الواجب عن المستحب إجتهادا أو تقليدا.
قال في الارشاد، في أوائل الصلاة: (يجب معرفة واجب أفعال الصلاة من مندوبها وإيقاع كل منهما على وجهه).
وحينئذ ففي الاحتياط إخلال بمعرفة الوجه التي أفتى جماعة بوجوبها وباطلاق بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد.
وفيه: أولا، أن معرفة الوجه مما يمكن، للمتأمل في الادلة وفي إطلاقات العبارات وفي سيرة
المسلمين وفي سيرة النبي، صلى الله عليه وآله، والائمة، عليهم السلام، مع الناس، الجزم بعدم إعتبارها، حتى مع التمكن من المعرفة العلمية.
ولذا ذكر المحقق، قدس سره، كما في محكي المدارك في باب الوضوء: (أن ما حققه المتكلمون من وجوب إيقاع الفعل لوجهه أو وجه وجوبه كلام شعري)، وتمام الكلام في غير هذا المقام.
وثانيا، لو سلمنا وجوب المعرفة أو إحتمال وجوبها الموجب للاحتياط، فإنما هو مع التمكن من المعرفة العلمية.
أما مع عدم التمكن فلا دليل عليه قطعا.
لان إعتبار معرفة الوجه إن كان لتوقف نية الوجه عليها، فلا يخفى أنه لا يجدي المعرفة الظنية في نية الوجه، فإن مجرد الظن بوجوب شئ لا يتأتى معه القصد إليه لوجوبه، إذ لا بد من الجزم بالنية.
ولو إكتفى بمجرد الظن بالوجوب ولو لم يكن نية حقيقة فهو مما لا يفي بوجوبه ما ذكروه في إشتراط نية الوجه.
نعم لو كان الظن المذكور مما ثبت وجوب العمل به، تحقق معه نية الوجه الظاهرى على سبيل الجزم.
لكن الكلام بعد في وجوب العمل بالظن.
فالتحقيق: أن الظن بالوجه إذا لم يثبت حجيته فهو كالشك فيه لا وجه لمراعاة نية الوجه معه أصلا.
وإن كان إعتبارها لاجل توقف الامتثال التفصيلي المطلوب عقلا أو شرعا عليه - ولذا أجمعوا ظاهرا على عدم كفاية الامتثال الاجمالي مع التمكن من التفصيلي بأن يتمكن من الصلاة إلى القبلة في مكان ويصلي في مكان آخر غير معلوم القبلة إلى أربع جهات أو يصلي في ثوبين مشتبهين أو أكثر، مرتين أو أكثر، مع إمكان صلاة واحدة في ثوب معلوم الطهارة، إلى غير ذلك - ففيه: إن ذلك إنما هو مع التمكن من العلم التفصيلي.
وأما مع عدم التمكن منه، كما في ما نحن فيه، فلا دليل على ترجيح الامتثال التفصيلي الظني على الامتثال الاجمالي العلمي، إذ لا دليل على ترجيح صلاة واحدة في مكان إلى جهة مظنونة على الصلاة المكررة في مكان مشتبه الجهة، بل بناء العقلاء في إطاعتهم العرفية على ترجيح العلم الاجمالي على الظن التفصيلي.
وبالجملة، فعدم جواز الاحتياط مع التمكن من تحصيل الظن مما لم يقم له وجه.
فإن كان ولا بد من إثبات العمل بالظن فهو بعد تجويز الاحتياط والاعتراف برجحانه وكونه مستحبا، بل لا يبعد ترجيح الاحتياط على تحصيل الظن الخاص الذي قام الدليل عليه بالخصوص، فتأمل.
نعم الاحتياط مع التمكن من العلم التفصيلي في العبادات مما انعقد الاجماع ظاهرا على عدم جوازه، كما أشرنا إليه في أول الرسالة، في مسألة إعتبار العلم الاجمالي وأنه كالتفصيلي من جميع الجهات أم لا، فراجع.
ومما ذكرنا ظهر أن القائل بإنسداد باب العلم وإنحصار المناص في مطلق الظن ليس له أن يتأمل في صحة عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد إذا أخذ بالاحتياط، لانه لم يبطل عند انسداد باب العلم إلا وجوب الاحتياط، لا جوازه أو رجحان.
فالاخذ بالظن عنده وترك الاحتياط عنده من باب الترخيص ودفع العسر والحرج، لا من باب العزيمة.
ثالثا، سلمنا تقديم الامتثال التفصيلي ولو كان ظنيا، على الاجمالي ولو كان علميا، لكن الجمع ممكن بين تحصيل الظن في المسألة ومعرفة الوجه ظنا والقصد إليه على وجه الاعتقاد الظني والعمل على الاحتياط.
مثلا، إذا حصل الظن بوجوب القصر في ذهاب أربعة فراسخ، فيأتي بالقصر بالنية الظنية الوجوبية ويأتي بالاتمام بقصد القربة إحتياطا أو بقصد الندب.
وكذلك إذا حصل الظن بعدم وجوب السورة في الصلاة، فينوي الصلاة الخالية عن السورة على وجه الوجوب، ثم يأتي بالسورة قربة إلى الله تعالى للاحتياط.
ورابعا، لو أغمضنا عن جميع ما ذكرنا فنقول: إن الظن إذا لم يثبت حجيته فقد كان اللازم يمقتضى العلم الاجمالي بوجود الواجبات والمحرمات في الوقائع المشتبهة هو الاحتياط، كما عرفت سابقا.
فإذا وجب الاحتياط حصل معرفة وجه العبادة وهو الوجوب، وتأتى نية الوجه الظاهري كما تأتى في جميع الموارد التي يفتي فيها الفقهاء بالوجوب من باب الاحتياط وإستصحاب الاشتغال فتأمل.
فتحصل مما ذكرنا أن العمدة في رد الاحتياط هي ما تقدم من الاجماع ولزوم العسر دون غيرهما.
اللهم إلا أن يقال: إن هناك شيئا ينبغي أن ينبه عليه: وهو أن نفي الاحتياط بالاجما والعسر لا يثبت إلا أنه لا يجب مراعاة جميع الاحتمالات مظنونها ومشكوكها وموهومها.
ويندفع العسر بترخيص موافقة الظنون المخالفة للاحتياط كلا أو بعضا، بمعنى عدم وجوب مراعاة الاحتمالات الموهومة، لانها الاولى بالاهمال.
وإذا ساغ لدفع الحرج ترك الاحتياط في مقدار ما من المحتملات يندفع به العسر، يبقى الاحتياط على حاله في الزائد على هذا المقدار.
لما تقرر في مسألة الاحتياط، من أنه إذا كان مقتضى الاحتياط هو الاتيان بمحتملات وقام الدليل الشرعي على عدم وجوب إتيان بعض المحتملات في الظاهر، تعين مراعاة الاحتياط في باقي المحتملات ولم يسقط وجوب الاحتياط رأسا.
توضيح ما ذكرنا: أنا نفرض المشتبهات التي علم إجمالا بوجود الواجبات الكثيرة فيها بين مظنونات الوجوب ومشكوكات الوجوب وموهومات الوجوب، وكان الاتيان بالكل عسرا أو قام
الاجماع على عدم وجوب الاحتياط في الجميع تعين ترك الاحتياط وإهماله في موهومات الوجوب.
بمعنى أنه إذا تعلق ظن بعدم الوجوب لم يجب الاتيان.
وليس هذا معنى حجية الظن، لان الفرق - بين المعنى المذكور، وهو أن مظنون عدم الوجوب لا يجب الاتيان به، وبين حجية الظن بمعنى كونه في الشريعة معيارا لامتثال التكاليف الواقعية نفيا وإثباتا.
وبعبارة أخرى: الفرق بين تبعيض الاحتياط في الموارد المشتبهة وبين جعل الظن فيها حجة - هو أن الظن إذا كان حجة في الشرع، كان الحكم في الواقعة الخالية عنه الرجوع إلى ما يقتضيه الاصل في تلك الواقعة من دون إلتفات إلى العلم الاجمالي بوجود التكاليف الكثيرة بين المشتبهات، إذ حال الظن حينئذ كحال العلم التفصيلي والظن الخاص بالوقائع، فيكون الوقائع بين معلومة الوجوب تفصيلا أو ما هو بمنزلة المعلوم وبين مشكوكة الوجوب رأسا.
وأما إذا لم يكن الظن حجة - بل كان غاية الامر، بعد قيام الاجماع ونفي الحرج على عدم لزوم الاحتياط في جميع الوقائع المشتبهة التي علم إجمالا بوجود التكاليف بينها، عدم وجوب الاحتياط بالاتيان بما ظن عدم وجوبه، لان ملاحظة الاحتياط في موهومات الوجوب خلاف الاجماع و موجب للعسر - كان اللازم في الواقعة الخالية عن الظن الرجوع إلى ما يقتضيه العلم الاجمالي المذكور من الاحتياط، لان سقوط الاحتياط في سلسلة الموهومات لا يقتضي سقوطه في المشكوكات، لاندفاع الحرج بذلك.
وحاصل ذلك: أن مقتضى القاعدة العقلية والنقلية لزوم الامتثال العلمي التفصيلي للاحكام والتكاليف المعلومة إجمالا.
ومع تعذره يتعين الامتثال العلمي الاجمالي، وهو الاحتياط المطلق.
ومع تعذره لو دار الامر بين الامتثال الظني في الكل وبين الامتثال العلمي الاجمالي في البعض والظني في الباقي كان الثاني هو المتعين عقلا ونقلا.
ففيما نحن فيه إذا تعذر الاحتياط الكلي ودار الامر بين إلغائه بالمرة والاكتفاء بالاطاعة الظنية وبين إعماله في المشكوكات والمظنونات وإلغائه في الموهومات كان الثاني هو المتعين.
ودعوى لزوم الحرج أيضا من الاحتياط في المشكوكات، خلاف الانصاف لقلة المشكوكات، لان الغالب حصول الظن إما بالوجوب وإما بالعدم.
اللهم إلا أن يدعى قيام الاجماع على عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات أيضا.
وحاصله: دعوى أن الشارع لا يريد الامتثال العلمي الاجمالي في التكاليف الواقعية المشتبهة بين الوقائع.
فيكون حاصل دعوى الاجماع دعوى إنعقاده على أنه لا يجب شرعا الاطاعة العلمية الاجمالية في
الوقائع المشتبهة مطلقا، لا في الكل ولا في البعض.
وحينئذ تعين الانتقال إلى الاطاعة الظنية.
لكن الانصاف: أن دعواه مشكلة جدا وان كان تحققه مظنونا بالظن القوي، لكنه لا ينفع ما لم ينته إلى حد العلم.
فإن قلت: إذا ظن بعدم وجوب الاحتياط في المشكوكات، فقد ظن بأن المرجع في كل مورد منها إلى ما يقتضيه الاصل الجاري في ذلك المورد، فيصير الاصول مظنونة الاعتبار في المسائل المشكوكة.
فالمظنون في تلك المسائل عدم وجوب الواقع فيها على المكلف وكفاية الرجوع إلى الاصول.
وسيجئ أنه لا فرق في الظن الثابت حجيته بدليل الانسداد بين الظن المتعلق بالواقع وبين الظن المتعلق بكون شئ طريقا إلى الواقع وكون العمل به مجزيا عن الواقع وبدلا عنه ولو تخلف عن الواقع.
قلت: مرجع الاجماع، قطعيا كان أو ظنيا، على الرجوع في المشكوكات إلى الاصول هو الاجماع على وجود الحجة الكافية في المسائل التي إنسد فيها باب العلم حتى تكون المسائل الخالية عنها موارد للاصول.
ومرجع هذا إلى دعوى الاجماع على حجية الظن بعد الانسداد.
[ قلت: مسالة إعتبار الظن بالطريق موقوف على هذه المسألة.
بيان ذلك أنه لو قلنا ببطلان لزوم الاحتياط في الشريعة رأسا من جهة إشتباه التكاليف الواقعية فيها وعدم لزوم الامتثال العلمي الاجمالي حتى في المشكوكات وكفاية الامتثال الظني في جميع تلك الواقعات المشتبهة، لم يكن فرق بين حصول الظن بنفس الواقع وبين حصول الظن بقيام شئ من الامور التعبدية مقام الواقع في حصول البراءة الظنية عن الواقع والظن بسقوط الواقع في الواقع أو في حكم الشارع وبحسب جعله.
أما لو لم يثبت ذلك، بل كان غاية ما ثبت هو عدم لزوم الاحتياط بإحراز الاحتمالات الموهومة للزم العسر، كان اللازم جواز العمل على خلاف الاحتياط في الوقائع المظنون عدم وجوبها أو عدم تحريمها.
وأما الوقائع المشكوك وجوبها أو تحريمها فهي باقية على طبق مقتضى الاصل من الاحتياط اللازم المراعاة، بل الوقائع المظنون وجوبها أو تحريمها يحكم فيها بلزوم الفعل أو الترك من جهة كونها من محتملات الواجبات والمحرمات الواقعية.
وحينئذ فإذا قام ما يظن كونه طريقا على عدم وجوب أحد الموارد المشكوك وجوبها، فلا يقاس
بالظن القائم على عدم وجوب مورد من الموارد المشتبهة في ترك الاحتياط، بل اللازم هو العمل بالاحتياط، لانه من الموارد المشكوكة، والظن بطريقية ما قام عليه لم يخرجه عن كونه مشكوكا.
وأنت خبير بأن جميع موارد الطرق المظنونة التي يراد إثبات إعتبار الظن بالطريق فيها إنما هي من المشكوكات، إذ لو كان نفس المورد مظنونا مع ظن الطريق القائم عليه لم يحتج إلى إعمال الظن بالطريق ولو كان مظنونا، بخلاف الطريق التعبدي المظنون كونه طريقا، لتعارض الظن الحاصل من الطريق والظن الحاصل في المورد على خلاف الطريق.
وسيجئ الكلام في حكمه على تقدير إعتبار الظن بالطريق.
والحاصل: أن إعتبار الظن بالطريق وكونه بالظن في الواقع مبني على القطع ببطلان الاحتياط رأسا، بمعنى أن الشارع لم يرد منا في مقام إمتثال الاحكام المشتبهة الامتثال العلمي الاجمالي حتى يستنتج من ذلك حكم العقل بكفاية الامتثال الظني لانه المتعين بعد الامتثال العلمي بقسميه من التفصيلي والاجمالي.
فيلزم من ذلك ما سنختاره من عدم الفرق بعد كفاية الامتثال الظني بين الظن بأداء الواقع والظن بمتابعة طريق جعله الشارع مجزيا عن الواقع.وسيجئ تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.ز ].
فإن قلت: إذا لم يقم في موارد الشك ما ظن طريقيته، لم يجب الاحتياط في ذلك المورد من جهة كونه أحد محتملات الواجبات أو المحرمات الواقعية وإن حكم بوجوب الاحتياط من جهة إقتضاء القاعدة في نفس المسألة.
كما لو كان الشك فيه في المكلف به.
وهذا إجماع من العلماء، حيث لم يحتط احد منهم في مورد الشك من جهة إحتمال كونه من الواجبات والمحرمات الواقعية، وإن إحتاط الاخباريون في الشبهة التحريمية من جهة مجرد إحتمال التحريم.
فإذا كان عدم وجوب الاحتياط إجماعيا مع عدم قيام ما يظن طريقيته على عدم الوجوب، فمع قيامه لا يجب الاحتياط بالاولوية القطعية.
قلت: العلماء إنما لم يذهبوا إلى الاحتياط في موارد الشك، لعدم العلم الاجمالي لهم بالتكاليف، بل الوقائع لهم بين معلوم التكليف تفصيلا أو مظنون لهم بالظن الخاص وبين مشكوك التكليف رأسا.
ولا يجب الاحتياط في ذلك عند المجتهدين بل عند غيرهم في الشبهة الوجوبية.
والحاصل: أن موضوع عمل العلماء بإنفتاح باب العلم أو الظن الخاص مغاير لموضوع عمل القائلين بالانسداد.
وقد نبهنا على ذلك غير مرة في بطلان التمسك لى بطلان البراءة والاحتياط بمخالفتهما لعمل العلماء، فراجع.
ويحصل مما ذكر إشكال آخر أيضا من جهة أن نفي الاحتياط بلزوم العسر لا يوجب كون الظن حجة ناهضة لتخصيص العمومات الثابتة بالظنون الخاصة ومخالفة سائر الظواهر الموجودة فيها.
ودعوى: (أن باب العلم والظن الخاص إذا فرض إنسداده سقط عمومات الكتاب والسنة المتواترة وخبر الواحد الثابت حجيته بالخصوص عن الاعتبار للعلم الاجمالي بمخالفة ظواهر أكثرها لمراد المتلكم، فلا يبقى ظاهر ههنا على حاله حتى يكون الظن الموجود على خلافه من باب المخصص والمقيد)، مجازفة، إذ لا علم ولا ظن بطرو مخالفة الظاره في غير الخطابات التي علم إجمالها بالخصوص.
مثل: أقيموا الصلاة، ولله على الناس حج البيت، وشبههما.
وأما كثير من العمومات التي لا نعلم بإجمال كل منها، فلا يعلم ولا يظن بثبوت المجمل بينها، لاجل طرو التخصيص في بعضها.وسيجئ بيان ذلك عند التعرض لحال نتيجة المقدمات إن شاء الله.هذا كله حال الاحتياط في جميع الوقائع.
وأما الرجوع في كل واقعة إلى ما يقتضيه الاصل في تلك الواقعة، من غير إلتفات إلى العلم الاجمالي بوجود الواجبات والمحرمات بين الوقائع، بأن يلاحظ نفس الواقعة: فإن كان فيها حكم سابق يحتمل بقاؤه إستصحب، كالماء المتغير بعد زوال التغيير.
وإلا فإن كان الشك في أصل التكليف، كشرب التتن، أجري البراءة، وإن كان الشك في تعيين المكلف به، مثل القصر والاتمام: فإن أمكن الاحتياط وجب، وإلا تخير، كما إذا كان الشك في تعيين التكليف الالزامي، كما إذا دار الامر بين الوجوب والتحريم.
فيرد هذا الوجه أن العلم الاجمالي بوجود الواجبات والمحرمات يمنع عن إجراء البراءة والاستصحاب المطابق لها المخالف للاحتياط، بل وكذا العلم الاجمالي بوجود غير الواجبات والمحرمات في الاستصحابات المطابقة للاحتياط يمنع من العمل بالاستصحابات من حيث أنها إستصحابات، وإن كان لا يمنع من العمل بها من حيث الاحتياط، فتأمل، لكن الاحتياط في جميع ذلك يوجب العسر.
وبالجملة، فالعمل بالاصول النافية للتكليف في مواردها مستلزم للمخالفة القطعية الكثيرة، وبالاصول المثبتة للتكليف من الاحتياط والاستصحاب مستلزم للحرج.وهذا لكثرة المشتبهات في المقامين، كما لا يخفى على المتأمل.
وأما رجوع هذا الجاهل الذي إنسد عليه باب العلم في المسائل المشتبهة إلى فتوى العالم بها و تقليده فيها، فهو باطل لوجهين:
أحدهما الاجماع القطعي.
والثاني أن الجاهل الذي وظيفته الرجوع
إلى العالم هو الجاهل العاجز عن الفحص.
وأما الجاهل الذي يبذل الجهد وشاهد مستند العالم وغلطه في إستناده إليه واعتقاده عنه، فلا دليل على حجية فتواه بالنسبة إليه.وليست فتواه من الطرق المقررة لهذا الجاهل.
فإن من يخطئ القائل بحجية خبر الواحد في فهم دلالة آية النبأ عليها، كيف يجوز له متابعته؟ وأي مزية له عليه؟ حتى يجب رجوع هذا إليه ولا يجب العكس.
وهذا هو الوجه فيما أجمع عليه العلماء، من أن المجتهد إذا لم يجد دليلا في المسألة على التكليف كان حكمه الرجوع إلى البراءة، لا إلى من يعتقد وجود دليل على التكليف.
والحاصل: أن إعتقاد مجتهد ليس حجة على مجتهد آخر خال عن ذلك الاعتقاد، وأدلة وجوب رجوع الجاهل إلى العالم يراد بها العالم الذي يختفي منشأ علمه على ذلك الجاهل، لا مجرد المعتقد بالحكم.
ولا فرق بين المجتهدين المعتقدين المختلفين في الاعتقاد وبين المجتهدين اللذين أحدهما اعتقد الحكم عن دلالة والاخر إعتقد بفساد تلك الدلالة، فلم يحصل له إعتقاد.
وهذا شئ مطرد في باب مطلق رجوع الجاهل إلى العالم، شاهدا كان أو مفتيا أو غيرهما.
المقدمة الرابعة في أنه إذا وجب التعرض لامتثال
الواقع في مسألة واحدة أو في مسائل
ولم يمكن الرجوع فيها إلى الاصول، ولم يجب أو لم يجز الاحتياط، تعين العمل فيها بمطلق الظن.ولعله لذلك يجب العمل بالظن في الضرر والعدالة وأمثالهما.إذا تمهدت هذه المقدمات فنقول: قد ثبت وجوب العمل بالظن فيما نحن فيه.
ومحصلها: أنه إذا ثبت إنسداد باب العلم والظن الخاص كما هو مقتضى المقدمة الاولى، وثبت وجوب إمتثال ] الاحكام المشتبهة وعدم جواز إهمالها بالمرة كما هو مقتضي المقدمة الثانية، وثبت عدم وجوب كون الامتثال على وجه الاحتياط وعدم جواز الرجوع فيه إلى الاصول الشرعية كما هو مقتضى المقدمة الثالثة: تعين بحكم العقل التعرض لامتثالها على وجه الظن بالواقع فيها، إذ ليس بعد الامتثال العلمي والظني بالظن الخاص المعتبر في الشريعة إمتثال مقدم على الامتثال الظني.
توضيح ذلك: أنه إذا وجب عقلا أو شرعا التعرض لامتثال الحكم الشرعي فله مراتب أربع:
الاولى: الامتثال العلمي التفصيلي.وهو أن ياتي بما يعلم تفصيلا أنه هو المكلف به.
وفي معناه ما إذا ثبت كونه هو المكلف به بالطريق الشرعي وإن لم يفد العلم ولا الظن، كالاصول الجارية في مواردها وفتوى المجتهد بالنسبة إلى الجاهل العاجز عن الاجتهاد.
الثانية: الامتثال العلمي الاجمالي، وهو يحصل بالاحتياط.
الثالثة: الامتثال الظني، وهو أن يأتي بما يظن أنه المكلف به.
الرابعة: الامتثال الاحتمالي، كالتعبد بأحد طرفي المسألة من الوجوب والتحريم أو التعبد
ببعض محتملات المكلف به عند عدم وجوب الاحتياط أو عدم إمكانه.
وهذه المراتب مترتبة لا يجوز بحكم العقل العدول عن سابقها إلى لاحقها إلا مع تعذرها، على إشكال في الاولين تقدم في أول الكتاب.
وحينئذ فإذا تعذرت المرتبة الاولى ولم يجب الثانية تعينت الثالثة، ولا يجوز الاكتفاء بالرابعة.
فاندفع بذلك: ما زعمه بعض من تصدى لرد دليل الانسداد بأنه لا يلزم من إبطال الرجوع إلى البراءة ووجوب العمل بالاحتياط وجوب العمل بالظن، لجواز أن يكون المرجع شيئا آخر لا نعلمه، مثل القرعة والتقليد أو غيرهما مما لا نعلمه.فعلى المستدل سد باب هذه الاحتمالات، والمانع يكفيه الاحتمال.
توضيح الاندفاع - بعد الاغماض عن الاجماع على عدم الرجوع إلى القرعة وما بعدها - أن مجرد إحتمال كون شئ غير الظن طريقا شرعيا لا يوجب العدول عن الظن إليه، لان الاخذ بمقابل المظنون قبيح في مقام إمتثال الواقع وإن قام عليه ما يحتمل أن يكون طريقا شرعيا، إذ مجرد الاحتمال لا يجدي في طرح الطرف المظنون، فإن العدول عن الظن إلى الوهم والشك قبيح.
والحاصل: أنه كما لا يحتاج الامتثال العلمي إلى جعل جاعل، فكذلك الامتثال الظني بعد تعذر الامتثال العلمي وفرض عدم سقوط الامتثال.
واندفع بما ذكرنا أيضا ما ربما يتوهم من التنافي بين إلتزام بقاء التكاليف في الوقائع المجهولة الحكم وعدم إرتفاعه بالجهل وبين إلتزام العمل بالظن نظرا إلى أن التكليف بالواقع لو فرض بقاؤه فلا يجدي غير الاحتياط وإحراز الواقع في إمتثاله.
توضيح الاندفاع: أن المراد من بقاء التكليف بالواقع نظير إلتزام بقاء التكليف فيما تردد الامر بين محذورين من حيث الحكم أو من حيث الموضوع بحيث لا يمكن الاحتياط، فإن الحكم بالتخيير لا ينافي إلتزام بقاء التكليف.
فيقال: إن الاخذ بأحدهما لا يجدي في إمتثال الواقع، لان المراد ببقاء التكليف عدم السقوط رأسا بحيث لا يعاقب عند ترك المحتملات، كلا، بل العقل يستقل بإستحقاق العقاب عند الترك رأسا، نظير جميع الوقائع المشتبهة.
فما نحن فيه نظير إشتباه الواجب بين الظهر والجمعة في يوم الجمعة بحيث يقطع بالعقاب بتركهما معا مع عدم إمكان الاحتياط أو كونه عسرا قد نص الشارع على نفيه مع وجود الظن باحدهما، فإنه يدور الامر بين العمل بالظن والتخيير والعمل بالموهوم.
فإن إيجاب العمل بكل من الثلاثة وإن لم يحرز به الواقع، إلا أن العمل بالظن أقرب إلى الواقع من العمل بالموهوم والتخيير فيجب عقلا،
فافهم ولا فرق في قبح طرح الطرف الراجح والاخذط بالمرجوح بين أن يقوم على المرجوح ما يحتمل أن يكون طريقا معتبرا شرعا وبين أن لا يقوم، لان العدول عن الظن إلى الوهم قبيح، ولو بإحتمال كون الطرف الموهوم واجب الاخذ شرعا، حيث قام عليه ما يحتمل كونه طريقا.
نعم لو قام على الطرف الموهوم ما يظن كونه طريقا معتبرا شرعيا ودار الامر بين تحصيل الظن بالواقع وبين تحصيل الظن بالطريق المعتبر الشرعي، ففيه كلام سيأتي إن شاء الله تعالى.
والحاصل: أنه - بعد ما ثبت بحكم المقدمة الثانية وجوب التعرض لامتثال المجهولات بنحو من الانحاء وحرمة إهمالها وفرضها كالمعدوم، وثبت بحكم المقدمة الثالثة عدم وجوب إمتثال المجهولات بالاحتياط وعدم جواز الرجوع في إمتثالها إلى الاصول الجارية في نفس تلك المسائل ولا إلى فتوى من يدعي إنفتاح باب العلم بها - تعين وجوب تحصيل الظن بالواقع فيها وموافقته، ولا يجوز قبل تحصيل الظن الاكتفاء بالاخذ بأحد طرفي المسألة، ولا بعد تحصيل الظن الاخذ بالطرف الموهوم، لقبح الاكتفاء في مقام الامتثال بالشك والوهم مع التمكن من الظن، كما يقبح الاكتفاء بالظن مع التمكن من العلم، ولا يجوز أيضا الاعتناء بما يحتمل أن يكون طريقا معتبرا مع عدم إفادته للظن، لعدم خروجه عن الامتثال الشكي أو الوهمي.
هذا خلاصة الكلام في مقدمات دليل الانسداد المنتجة لوجوب العمل بالظن في الجملة.
امور ينبغي التنبيه عليها الامر الاول: لا فرق في الامتثال الظني بين
الحكم الواقعي والحكم الظاهري
إنك قد عرفت أن قضية المقدمات المذكورة وجوب الامتثال الظني للاحكام المجهولة، فاعلم أنه لا فرق في الامتثال الظني بين تحصيل الظن بالحكم الفرعي الواقعي، كأن يحصل من شهرة القدماء الظن بنجاسة العصير العنبي، وبين تحصيل الظن بالحكم الفرعي الظاهري، كأن يحصل من أمارة الظن بحجية أمر لا يفيد الظن، كالقرعة مثلا.
فإذا ظن حجية القرعة حصل الامتثال الظني في مورد القرعة، وإن لم يحصل ظن بالحكم الواقعي، إلا أنه حصل ظن ببراءة ذمة المكلف في الواقعة الخاصة، وليس الواقع بما هو واقع مقصودا للمكلف إلا من حيث كون تحققه مبرءا للذمة.
فكما أنه لا فرق في مقام التمكن من العلم بين تحصيل العلم بنفس الواقع وبين تحصيل العلم بموافقة طريق علم كون سلوكه مبرءا للذمة في نظر الشارع، فكذا لا فرق عند تعذر العلم بين الظن بتحقق الواقع وبين الظن ببراءة الذمة في نظر الشارع.وقد خالف في هذا التعميم فريقان.
أحدهما: من يرى أن مقدمات دليل الانسداد لا تثبت إلا إعتبار الظن وحجيته في كون الشئ طريقا شرعيا مبرءا للذمة في نظر الشارع ولا تثبت إعتباره في نفس الحكم الفرعي، زعما منهم عدم نهوض المقدمات المذكورة لاثبات حجية الظن في نفس الاحكام الفرعية، إما مطلقا أو بعد العلم الاجمالي بنصب الشارع طرقا للاحكام الفرعية.
الثاني: مقابل هذا، وهو من يرى أن المقدمات المذكورة لا تثبت إلا إعتبار الظن في نفس الاحكام الفرعية.
أما الظن بكون الشئ طريقا مبرءا للذمة فهو ظن في المسألة الاصولية لم يثبت إعتباره فيها من دليل الانسداد، لجريانها في المسائل الفرعية دون الاصولية.
وأما الطائفة الاولى فقد ذكروا لذلك وجهين.
أحدهما - وهو الذي إقتصر عليه بعضهم - ما لفظه: (إنا كما نقطع بأنا مكلفون في زماننا هذا تكليفا فعليا بأحكام فرعية كثيرة، ولا سبيل لنا بحكم العيان و شهادة الوجدان إلى تحصيل كثير منها بالقطع ولا بطريق معين نقطع من السمع بحكم الشارع بقيامه أو قيام طريقه مقام القطع ولو عند تعذره، كذلك نقطع بأن الشارع قد جعل لنا إلى تلك الاحكام طرقا مخصوصة وكلفنا تكليفا فعليا بالرجوع إليها في معرفتها.
ومرجع هذين القطعين عند التحقيق إلى أمر واحد، وهو القطع بأنا مكلفون تكليفا فعليا بالعمل بمؤدى طرق مخصوصة.
وحيث أنه لا سبيل غالبا إلى تعيينها بالقطع ولا بطريق نقطع عن السمع بقيامه بالخصوص أو قيام طريقه، كذلك مقام القطع ولو بعد تعذره.
فلا ريب أن الوظيفة في مثل ذلك بحكم العقل إنما هو الرجوع في تعيين تلك الطرق إلى الظن الفعلي الذي لا دليل على عدم حجيته، لانه أقرب إلى العلم وإلى إصابة الواقع مما عداه).
وفيه: أولا، إمكان منع نصب الشارع طرقا خاصة للاحكام الواقعية وافية بها.
كيف؟ وإلا لكان وضوح تلك الطرق كالشمس في رائعة النهار، لتوفر الدواعي بين المسلمين على ضبطها، لاحتياج كل مكلف إلى معرفتها أكثر من حاجته إلى معرفة صلواته الخمس.
وإحتمال إختفائها مع ذلك - لعروض دواعي الاختفاء، إذ ليس الحاجة إلى معرفة الطريق أكثر من الحاجة إلى معرفة المرجع بعد النبي، صلى الله عليه وآله - مدفوع بالفرق بينهما، كما لا يخفى.
وكيف كان، فيكفي في رد الاستدلال إحتمال عدم نصب الطريق الخاص للاحكام وإرجاع إمتثالها إلى ما يحكم به العقلاء وجرى عليه ديدنهم في إمتثال أحكام الملوك والموالي مع العلم بعدم نصب الطريق الخاص للاحكام، من الرجوع إلى العلم الحاصل من تواتر النقل عن صاحب الحكم أو بإجتماع جماعة من أصحابه على عمل خاص أو الرجوع إلى الظن الاطميناني
الذي يسكن إليه النفس ويطلق عليه العلم عرفا، ولو تسامحا، في إلقاء إحتمال الخلاف.
وهو الذي يحتمل حمل كلام السيد عليه، حيث إدعى إنفتاح باب العلم، هذا حال المجتهد.
وأما المقلد، فلا كلام في نصب الطريق الخاص له، وهو فتوى مجتهده، مع إحتمال عدم النصب في حقه أيضا، فيكون رجوعه إلى المجتهد من باب الرجوع إلى أهل الخبرة المركوز في أذهان جميع العقلاء، ويكون بعض ما ورد من الشارع في هذا الباب تقريرا لهم، لا تأسيسا.
وبالجملة، فمن المحتمل قريبا إحالة الشارع للعباد في طريق إمتثال الاحكام إلى ما هو المتعارف بينهم في إمتثال أحكامهم العرفية من الرجوع إلى العلم او الظن الاطميناني.
فإذا فقدا تعين الرجوع ايضا بحكم العقلاء إلى الظن الغير الاطميناني، كما أنه لو فقد - والعياذ بالله - الامارات المفيدة لمطلق الظن، لتعين الامتثال باخذ أحد طرفي الاحتمال فرارا عن المخالفة القطعية والاعراض عن التكاليف الالهية الواقعية.
فظهر مما ذكرنا إندفاع ما يقال من أن منع نصب الطريق لا يجامع القول ببقاء الاحكام الواقعية، إذ بقاء التكليف من دون نصب طريق إليها ظاهر البطلان.
توضيح الاندفاع: أن التكليف إنما يقبح مع عدم ثبوت الطريق رأسا، ولو بحكم العقل الحاكم بالعمل بالظن، مع عدم الطريق الخاص أو مع ثبوته وعدم رضاء الشارع بسلوكه، وإلا فلا يقبح التكليف مع عدم الطريق الخاص وحكم العقل بمطلق الظن ورضاء الشارع به.
ولهذا إعترف هذا المستدل على أن الشارع لم ينصب طريقا خاصا يرجع إليه عند إنسداد باب العلم في تعيين الطرق الخاصة الشرعية مع بقاء التكليف بها.
وربما يستشهد للعلم الاجمالي بنصب الطريق بان المعلوم من سيرة العلماء في إستنباطهم هو إتفاقهم على طريق خاص وإن إختلفوا في تعيينه.
وهو ممنوع، اؤلا، بأن جماعة من أصحابنا، كالسيد رحمه الله، وبعض من تقدم عليه وتأخر عنه، منعوا نصب الطريق الخاص رأسا بل أحاله بعضهم.
وثانيا، لو أغمضنا عن مخالفة السيد وأتباعه، لكن مجرد قول كل من العلماء بحجية طريق خاص حسب ما أدى إليه نظره لا يوجب العلم الاجمالي بأن بعض هذه الطرق منصوبة، لجواز خطأ كل واحد فيما أدى إليه نظره.
وإختلاف الفتاوى في الخصوصيات لا يكشف عن تحقق القدر المشترك، إلا إذا كان إختلافهم راجعا إلى التعيين على وجه ينبئ عن إتفاقهم على قدر مشترك.
نظير الاخبار المختلفة في الوقائع المختلفة، فإنها لا توجب تواتر القدر المشترك، إلا إذا علم من
أخبارهم كون الاختلاف راجعا إلى التعيين.
وقد حقق ذلك في باب التواتر الاجمالي والاجماع المركب، وربما يجعل تحقق الاجماع على المنع عن العمل بالقياس وشبهه ولو مع إنسداد باب العلم كاشفا عن أن المرجع إنما هو طريق خاص.
وينتقض:
أولا، بأنه مستلزم لكون المرجع في تعيين الطريق أيضا طريقا خاصا للاجماع على المنع عن العمل فيه بالقياس.
ويحل:
ثانيا، بأن مرجع هذا إلاشكال الاتي في خروج القياس عن مقتضى دليل الانسداد، فيدفع بأخذ الوجوه الاتية.
فإن قلت: ثبوت الطريق إجمالا مما لا مجال لانكاره، حتى على مذهب من يقول بالظن المطلق، فإن غاية الامر أنه يجعل مطلق الظن طريقا عقليا رضي به الشارع.
فنصب الشارع للطريق بالمعنى الاعم من الجعل والتقرير معلوم.
قلت: هذه مغالطة، فإن مطلق الظن ليس طريقا في عرض الطرق المجعولة حتى يتردد الامر بين كون الطريق هو مطلق الظن أو طريقا آخر مجعولا، بل الطريق العقلي بالنسبة إلى الطريق الجعلي كالاصل بالنسبة إلى الدليل.
إن وجد الطريق الجعلي لم يحكم العقل بكون الظن طريقا، لان الظن بالواقع لا يعمل به في مقابلة القطع ببراءة الذمة، وإن لم يوجد كان طريقا، لان إحتمال البراءة لسلوك الطريق المحتمل لا يلتفت إليه مع الظن بالواقع.
فمجرد عدم ثبوت الطريق الجعلي، كا في ما نحن فيه، كاف في حكم العقل بكون مطلق الظن طريقا.
وعلى كل حال فتردد الامر بين مطلق الظن وطريق خاص آخر مما لا معنى له.
وثانيا، سلمنا نصب الطريق، لكن بقاء ذلك الطريق لنا غير معلوم.
بيان ذلك: أن ما حكم بطريقيته لعله قسم من الاخبار ليس منه بأيدينا اليوم إلا قليل، كأن يكون الطريق المنصوب هو الخبر المفيد للاطمينان الفعلي بالصدور الذي كان كثيرا في الزمان السابق لكثرة القرائن، ولا ريب في ندرة هذا القسم في هذا الزمان أو خبر العادل أو الثقة الثابت عدالته أو وثاقته بالقطع أو البينة الشرعية أو الشياع مع إفادته الظن الفعلي بالحكم.
ويمكن دعوى ندرة هذا القسم في هذا الزمان، إذ غاية الامر أن نجد الراوي في الكتب الرجالية محكي التعديل بوسائط عديدة، من مثل الكشي والنجاشي وغيرهما.ومن المعلوم أن مثل هذا لا تعد بينة شرعية، ولذا لا يقبل مثله في الحقوق.
ودعوى حجية مثل ذلك بالاجماع ممنوعة، بل المسلم أن الخبر المعدل بمثل هذا حجة بالاتفاق.
لكن قد عرفت سابقا عند تقرير الاجماع على
حجية خبر الواحد أن مثل هذا الاتفاق العملي لا يجدي في الكشف عن قول الحجة، مع أن مثل هذا الخبر في غاية القلة، خصوصا إذا إنضم إليه إفادة الظن الفعلي.
وثالثا: سلمنا نصب الطريق ووجوده في جملة ما بأيدينا من الطرق الظنية، من أقسام الخبر والاجماع المنقول والشهره، وظهور الاجماع والاستقراء والاولوية الظنية، إلا أن اللازم من ذلك هو الاخذ بما هو المتيقن من هذه.
فإن وفى بغالب الاحكام اقتصر عليه، وإلا فالمتيقن من الباقي.
مثلا، الخبر الصحيح والاجماع المنقول متيقن بالنسبة إلى الشهرة وما بعدها من الامارات، إذ لم يقل أحد بحجية الشهرة وما بعدها دون الخبر الصحيح والاجماع المنقول.
فلا معنى لتعيين الطريق بالظن بعد وجود القدر المتيقن ووجوب الرجوع في المشكوك إلى أصالة حرمة العمل.
نعم لو احتيج إلى العمل بإحدى أمارتين واحتمل نصب كل منهما، صح تعيينه بالظن بعد الاغماض عما سيجئ من الجواب.
ورابعا لو سلمنا عدم وجود القدر المتيقن، لكن اللازم من ذلك وجوب الاحتياط، لانه مقدم على العمل بالظن، لما عرفت من تقديم الامتثال العلمي على الظني، اللهم إلا أن يدل دليل على عدم وجوبه، وهو في المقام مفقود.
ودعوى: (أن الامر دائر بين الواجب والحرام، لان العمل بما ليس طريقا حرام)، مدفوعة: بأن العمل بما ليس طريقا إذا لم يكن على وجه التشريع غير محرم، والعمل بكل ما يحتمل الطريقية رجاء أن يكون هذا هو الطريق لا حرمة فيه من جهة التشريع.
نعم، قد عرفت أن حرمته مع عدم قصد التشريع إنما هي من جهة أن فيه طرحا للاصول المعتبرة من دون حجة شرعية.
وهذا أيضا غير لازم في المقام، لان مورد العمل بالطريق المحتمل إن كان الاصول على طبقه فلا مخالفة، وإن كان مخالفا للاصول: فإن كان مخالفا للاستصحاب النافي للتكليف فلا إشكال، لعدم حجية الاستصحابات بعد العلم الاجمالي بأن بعض الامارات الموجودة على خلافها معتبرة عند الشارع وإن كان مخالفا للاحتياط، فحينئذ يعمل بالاحتياط في المسألة الفرعية، وكذا لو كان مخالفا للاستصحاب المثبت للتلكيف.
فحاصل الامر يرجع إلى العمل بالاحتياط في المسألة اصولية، أعني نصب الطريق إذا لم يعارضه الاحتياط في المسألة الفرعية.فالعمل مطلقا على الاحتياط.
اللهم إلا أن يقال إنه يلزم الحرج من الاحتياط في موارد جريان الاحتياط في نفس المسألة، كالشك في الجزئية وفي موارد الاستصحابات المثبتة للتكليف والنافية له بعد العلم الاجمالي بوجوب العمل في بعضها على
خلاف الحالة السابقه، إذ يصير حينئذ كالشبهة المحصوره، فتأمل.
وخامسا، سلمنا العلم الاجمالي بوجود الطريق المجعول وعدم المتيقن وعدم وجوب الاحتياط.
لكن نقول: إن ذلك لا يوجب تعيين العمل بالظن في مسألة تعيين الطريق فقط، بل هو مجوز له، كما يجوز العمل بالظن في المسألة الفرعية.
و ذلك، لان الطريق المعلوم نصبه إجمالا، إن كان منصوبا حتى إنفتاح باب العلم، فيكون هو في عرض الواقع مبرءا للذمة، بشرط العلم به، كالواقع المعلوم.
مثلا، إذا فرضنا حجية الخبر مع الانفتاح، تخير المكلف بين إمتثال ما علم كونه حكما واقعيا بتحصيل العلم به وبين إمتثال مؤدى الطريق المجعول الذي علم جعله بمنزلة الواقع.فكل من الواقع ومؤدى الطريق مبرء مع العلم به.
فإذا إنسد باب العلم التفصيلي بأحدهما تعين الاخر، وإذا باب العلم التفصيلي بهما تعين العمل فيهما بالظن.
فلا فرق بين الظن بالواقع والظن بمؤدى الطريق، في كون كل واحد منهما إمتثالا ظنيا.
وإن كان ذلك الطريق منصوبا عند إنسداد باب العلم بالواقع، فنقول: إن تقديمه حينئذ على العمل بالظن إنما هو مع العلم به وتمييزه عن غيره، إذ حينئذ يحكم العقل بعدم جواز العمل بمطلق الظن مع وجودذ هذا الطريق المعلوم، إذ فيه عدول عن الامتثال القطعي إلى الظني، فكذا مع العلم الاجمالي، بناء على أن الامتثال التفصيلي مقدم على الاجمالي أو لان الاحتياط يوجب الحرج المؤدي إلى الاختلال.
أما مع إنسداد باب العلم بهذا الطريق وعدم تميزه عن غيره إلا بإعمال مطلق الظن، فالعقل لا يحكم بتقديم إحراز الطريق بمطلق الظن على إحراز الواقع بمطلق الظن.
وكأن المستدل توهم أن مجرد نصب الطريق ولو مع عروض الاشتباه فيه موجب لصرف التكليف عن الواقع إلى العمل بمؤدى الطريق كما ينبئ عنه قوله.
وحاصل القطعين إلى أمر واحد، وهو التكليف الفعلي بالعمل بمؤديات الطرق.
وسيأتي مزيد توضيح لاندفاع هذا التوهم إن شاء الله تعالى.
فإن قلت: نحن نرى أنه إذ عين الشارع طريقا للواقع عند إنسداد باب العلم به، ثم إنسد باب العلم بذلك الطريق، كان البناء على العمل بالظن في الطريق دون نفس الواقع.
ألا ترى أن المقلد يعمل بالظن في تعيين المجتهد لا في نفس الحكم الواقعي، والقاضي يعمل بالظن في تحصيل الطرق المنصوبة لقطع المرافعات، لا في تحصيل الحق الواقعي بين المتخاصمين
قلت: فرق بين ما نحن فيه وبين المثالين، فإن الظنون الحاصلة للمقلد والقاضي في المثالين بالنسبة إلى نفس الواقع أمور غير مضبوطة كثيرة المخالفة للواقع مع قيام الاجماع على عدم جواز العمل بها، كالقياس، بخلاف ظنونهما المعمولة في تعيين الطريق، فإنها حاصلة من أمارات منضبطة غالبة المطابقة لم يدل دليل بالخصوص على عدم جواز العمل بها.
فالمثال المطابق لما نحن فيه أن يكون الظنون المعمولة في تعيين الطريق بعينها هي المعمولة في تحصيل الواقع، لا يوجد بينهما فرق من جهة العلم الاجمالي بكثرة مخالفة إحداهما للواقع، ولا من جهة منع الشارع عن إحداهما بالخصوص.
كما أنا لو فرضنا أن الظنون المعمولة في نصب الطريق على العكس في المثالين كان المتعين العمل بالظن في نفس الواقع دون الطريق.
فما ذكرنا، من العمل على الظن، سواء تعالق بالطريق أن بنفس الواقع، فإنما هو مع مساواتهما من جميع الجهات.
فإنا لو فرضنا أن المقلد يقدر على إعمال نظير الظنون التي يعملها لتعيين المجتهد في الاحكام الشرعية مع قدرة الفحص عما يعارضها على الوجه المعتبر في العمل بالظن، لم يجب عليه العمل بالظن في تعيين المجتهد، بل وجب عليه العمل بظنه في تعيين الحكم الواقعي.
وكذا القاضي إذا شهد عنده عادل واحد بالحق لا يعمل به، وإذا أخبره هذا العادل بعينه بطريق قطع هذه المخاصمة يأخذ به.
فإنما هو لاجل قدرته على الاجتهاد في مسأله الطريق بإعمال الظنون وبذل الجهد في المعارضات ودفعها.
بخلاف الظن بحقية أحد المتخاصمين، فإنه مما يصعب الاجتهاد وبذل الوسع في فهم الحق من المتخاصمين، لعدم إنضباط الامارات في الوقائع الشخصية وعدم قدرة المجتهد على الاحاطه بها حتى يأخذ بالاحرى.
وكما أن المقلد عاجز عن الاجتهاد في المسألة الكلية، كذلك القاضي عاجز عن الاجتهاد في الوقائع الشخصية، فتأمل.
هذا، مع إمكان أن يقال: إن مسألة عمل القاضي بالظن في الطريق مغايرة لمسألتنا، من جهة أن الشارع لم يلاحظ الواقع في نصب الطريق وأعرض عنه، وجعل مدار قطع الخصومة على الطرق التعبدية، مثل الاقرار والبينة واليمين والنكول والقرعة وشبهها، بخلاف الطرق المنصوبة للمجتهد على الاحكام الواقعية، فإن الظاهر أن مبناها على الكشف الغالبي عن الواقع، ووجه تخصيصها من بين سائر الامارات كونها أغلب مطابقة للواقع وكون غيرها غير غالب المطابقة، بل غالب المخالفة.
كما ينبئ عنه ما ورد في العمل بالعقول في دين الله: (وإنه ليس شئ أبعد عن دين الله من عقول الرجال، وإن ما يفسده أكثر مما يصلحه، وإن الدين يمحق بالقياس،
ونحو ذلك).
ولا ريب أن المقصود من نصب الطريق إذا كان غلبة الوصول إلى الواقع لخصوصية فيها من بين سائر الامارات، ثم إنسد باب العلم بذلك الطريق المنصوب والتجا إلى إعمال سائر الامارات التي لم يعتبرها الشارع في نفس الحكم لوجوب الاوفق منها بالواقع، فلا فرق بين إعمال هذه الامارات في تعيين ذلك الطريق وبين إعمالها في نفس الحكم الواقعي.
بل الظاهر أن إعمالها في نفس الواقع أولى لاحراز المصلحة الاولية التي هي أحق بالمراعاة من مصلحة نصب الطريق، فإن غاية ما في نصب الطريق من المصلحة ما به يتدارك المفسدة المترتبة على مخالفة الواقع اللازمة من العمل بذلك الطريق، لا إدراك المصلحة الواقعية.
ولهذا إتفق العقل والنقل على ترجيح الاحتياط على تحصيل الواقع بالطريق المنصوب في غير العبادات مما لا يعتبر فيه نية الوجه إتفاقا، بل الحق ذلك فيها أيضا، كما مرت الاشارة إليه في إبطال وجوب الاحتياط.
فإن قلت: العمل بالظن في الطريق عمل بالظن في الامتثال الظاهري والواقعي، لان الفرض إفادة الطريق للظن بالواقع، بخلاف غير ما ظن طريقيته، فإنه ظن بالواقع وليس ظنا بتحقق الامتثال في الظاهر، بل الامتثال الظاهري مشكوك أو موهوم بحسب إحتمال إعتبار ذلك الظن.
قلت: أولا، إن هذا خروج عن الفرض، لان مبنى الاستدلال المتقدم على وجوب العمل بالظن في الطريق وإن لم يكن الطريق مفيدا للظن به أصلا.
نعم قد إتفق في الخارج أن الامور التي يعلم بوجود الطريق فيها إجمالا مفيدة للظان شخصا أو نوعا، لا أن مناط الاستدلال إتباع الظن بالطريق المفيد للظن بالواقع.
وثانيا، إن هذا يرجع إلى ترجيح بعض الامارات الظنية على بعض بإعتبار الظن بإعتبار بعضها شرعا دون الاخر، بعد الاعتراف بأن مؤدى دليل الانسداد حجية الظن بالواقع لا بالطريق.
وسيجئ الكلام في أن نتيجة دليل الانسداد على تقدير إفادته إعتبار الظن بنفس الحكم كلية بحيث لا يرجح بعض الظنون على بعض أو مهملة بحيث يجب الترجيح بين الظنون، ثم التعميم مع فقد المرجح؟ والاستدلال المذكور مبني على إنكار ذلك كله، وأن دليل الانسداد جار في مسألة تعيين
الطريق وهي المسألة الاصولية، لا في نفس الاحكام الواقعية الفرعية، بناء منه على أن الاحكام الواقعية بعد نصب الطرق ليست مكلفا بها تكليفا فعليا إلا بشرط قيام تلك الطرق عليها.فالمكلف به في الحقيقة مؤديات تلك الطرقن لا الاحكام الواقعية من حيث هي.
وقد عرفت مما ذكرنا أن نصب هذه الطرق ليس إلا لاجل كشفها الغالبي عن الواقع ومطابقتها له.
فإذا دار الامر بين إعمال الظن في تعيينها أو في تعيين الواقع لم يكن رجحان للاول.
ثم إذا فرضنا أن نصبها ليس لمجرد الكشف، بل لاجل مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع، لكن ليس مفاد نصبها تقييد الواقع بها وإعتبار مساعدتها في إرادة الواقع، بل مؤدى وجوب العمل بها جعلها عين الواقع ولو بحكم الشارع، لا قيدا له.
والحاصل: أنه فرق بين أن يكون مرجع نصب هذه الطرق إلى قول الشارع: (لا أريد منه الواقع إلا ما ساعد عليه ذلك الطريق)، فينحصر التكليف الفعلي حينئذ في مؤديات الطرق، ولازمه إهمال ما لم يؤد إليه الطريق من الواقع، سواء إنفتح باب العلم بالطريق أم إنسد، وبين أن يكون التكليف الفعلي بالواقع باقيا على حاله، إلا أن الشارع حكم بوجوب البناء على كونت مؤدى الطريق هو ذلك الواقع فمؤدى هذه الطرق واقع جعلي.
فإذا إنسد طريق العلم إليه ودار الامر بين الظن بالواقع الحقيقي وبين الظن بما جعله الشارع واقعا، فلا ترجيح، إذ الترجيح مبني على إغماض الشارع عن الواقع.
وبذلك ظهر ما في قول بعضهم من: (أن التسوية بين الظن بالواقع والظن بالطريق إنما تحسن لو كان أداء التكليف المتعلق بكل من الفعل والطريق المقرر مستقلا، لقيام الظن بكل من التكليفين حينئذ مقام العلم به مع قطع النظر عن الاخر.
وأما لو كان أحد التكليفين منوطا بالاخر مقيدا له، فمجرد حصول الظن بأحدهما دون حصول الظن بالاخر المقيد له لا يقتضي الحكم بالبراءة.
وحصول البراءة في صورة العلم بأداء الواقع إنما هو لحصول الامرين به، نظرا إلى أداء الواقع وكونه من الوجه المقرر لكون العلم طريقا إلى الواقع في العقل والشرع.
فلو كان الظن بالواقع ظنا بالطريق جرى ذلك فيه أيضا، لكنه ليس كذلك، فلذا لا يحكم بالبراءة معه) إنتهى.
الوجه الثاني ما ذكره بعض المحققين من المعاصرين مع الوجه الاول وبعض الوجوه الاخر، قال: (لا ريب في كوننا مكلفين بالاحكام الشرعية، ولم يسقط عنا التكليف بالاحكام الشرعية في الجملة، وأن الواجب علينا أولا هو تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكم المكلف بأن يقطع معه بحكمه بتفريغ ذمتنا عما كلفنا به وسقوط التكليف عنا، سواء حصل العلم منه بأداء الواقع أولا، حسب ما مر تفصيل القول فيه.
وحينئذ، فنقول: إن صح لنا تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكم الشارع فلا إشكال في وجوبه وحصول البراءة به، وإن إنسد علينا سبيل العلم به كان الواجب علينا تحصيل الظن بالبراءه في حكمه.
إذ هو الاقرب إلى العلم به، فتعين الاخذ به عند التنزل من العلم في حكم العقل بعد إنسداد سبيل العلم به والقطع ببقاء التكليف، دون ما يحصل معه الظن بأداء الواقع، كما يدعيه القائل بأصالة حجية الظن.
وبينهما بون بعيد، إذ المعتبر في الوجه الاول هو الاخذ بما يظن كونه حجة بقيام دليل ظني على حجيته، سواء حصل منه الظن بالواقع أولا.
وفي الوجه الثاني لا يلزم حصول الظن بالبراءة في حكم الشارع، إذ لا يستلزم مجرد الظن بالواقع الظن بإكتفاء المكلف بذلك الظن في العمل، سيما بعد النهي عن إتباع الظن.
فإذا تعين تحصيل ذلك بمقتضى حكم العقل، حسب ما عرفت، يلزم إعتبار أمر آخر يظن معه رضى المكلف بالعمل به.
وليس ذلك إلا الدليل الظني الدال على حجيته.
فكل طريق قام دليل ظني على حجيته وإعتباره عند الشارع، يكون حجة دون ما لم يقم عليه ذلك، إنتهى بألفاظه.
وأشار بقوله: (حسب ما مر تفصيل القول فيه)، إلى ما ذكره سابقا في مقدمات هذا المطلب، حيث قال - في المقدمة الرابعة من تلك المقدمات -:
(إن المناط في وجوب الاخذ بالعلم وتحصيل اليقين من الدليل: هل هو اليقين بمصادفة الاحكام الواقعية الاولية إلا أن يقول دليل على الاكتفاء بغيره؟ أو أن الواجب أول هو تحصيل اليقين بتحصيل الاحكام وأداء الاعمال على وجه أراده الشارع منا في الظاهر، وحكم معه قطعا بتفريغ ذمتنا، بملاحظة الطرق المقررة لمعرفتها مما جعلها وسيلة للوصول إليها، سواء علم مطابقته للواقع أو ظن ذلك، أو لم يحصل به شئ منهما؟ وجهان.
الذي يقتضيه التحقيق هو الثاني، فإنه القدر الذي يحكم العقل بوجوبه ودلت الادلة المتقدمه على إعتباره.
ولو حصل العلم بها على الوجه المذكور، لم يحكم العقل قطعا بوجوب تحصيل العلم بما في الواقع، ولم يقض شئ من الادلة الشرعية بوجوب تحصيل شئ آخر وراء ذلك، بل الادلة الشرعية قائمة على خلاف ذلك، إذ لم يبن الشريعة من أول الامر على وجوب تحصيل كل من الاحكام الواقعية على سبيل القطع واليقين، ولم يقع التكليف به حين إنفتاح سبيل العلم بالواقع.
وفي ملاحظة طريقة السلف من زمن النبي، صلى الله عليه وآله، والائمة، عليهم السلام، كفاية في ذلك، إذ لم يوجب النبي - صلى الله عليه وآله - على جميع من في بلده من الرجال والنسوان السماع منه في تبليغ الاحكام، أو حصول التواتر لآحادهم بالنسبة إلى آحاد الاحكام، أو قيام القرينة القاطعة على عدم تعمد الكذب أو الغلط في الفهم أو في سماع اللفظ بالنظر إلى الجميع، بل لو سمعوه من الثقة إكتفوا به)، إنتهى.
ثم شرع في إبطال دعوى حصول العلم بقول الثقة مطلقا - إلى أن قال -: (فتحصل مما قررناه أن العلم الذي هو مناط التكليف أولا هو العلم بالاحكام من الوجه المقرر لمعرفتها والوصول إليها، والواجب بالنسبة إلى العمل هو أداؤه على وجه يقطع معه بتفريغ الذمة في حكم الشرع، سواء حصل العلم بأدائه على طبق الواقع أو على طبق الطريق المقرر من الشارع، وإن لم يعلم أو لم يظن بمطابقتها للواقع.
وبعبارة أخرى، لا بد من المعرفة بالتكليف وأداء المكلف به على وجه اليقين أو على وجه منته إلى اليقين، من غير فرق بين الوجهين ولا ترتيب بينهما نعم، لو لم يظهر طريق مقرر من الشارع لمعرفتها تعين الاخذ بالعلم بالواقع على حسب إمكانه، إذ هو طريق إلى الواقع بحكم العقل من غير توقف لايصاله إلى الواقع على بيان الشرع، بخلاف غيره من الطرق المقررة)، إنتهى كلامه، رفع مقامه.
أقول: ما ذكره في مقدمات مطلبه من عدم الفرق بين علم المكلف بأداء الواقع على ما هو عليه وبين العلم بأدائه من الطريق المقرر مما لا إشكال فيه.
نعم ما جزم به - من أن المناط في تحصيل العلم أولا هو العلم بتفريغ الذمة دون أداء الواقع على ما هو عليه - فيه: أن تفريغ الذمة عما إشتغلت به إما بفعل نفس ما أراده الشارع في ضمن الاوامر الواقعية وإما بفعل ما حكم حكما جعليا بأنه نفس المراد، وهو مضمون الطرق المجعولة، فتفريغ الذمة بهذا على مذهب المخطئه من حيث أنه نفس المراد الواقعي بجعل الشارع، لا من حيث أنه شئ مستقل في مقابل المراد الواقعي، فضلا عن أن يكون هو المناط في لزوم تحصيل العلم واليقين.
والحاصل: أن مضمون الاوامر الواقعية المتعلقة بأفعال المكلفين مراد واقعي حقيقي.
ومضمون الاوامر الظاهرية المتعلقه بالعمل بالطرق المقررة ذلك المراد الواقعي، لكن على سبيل الجعل، لا الحقيقة.
وقد إعترف المحقق المذكور، حيث عبر عنه بأداء الواقع من الطريق المجعول.
فأداء كل من الواقع الحقيقي والواقع الجعلي لا يكون بنفسه إمتثالا وإطاعة للامر المتعلق به ما لم يحصل العلم به.
نعم لو كان كل من الامرين المتعلقين بالادائين مما لا يعتبر في سقوطه قصد الاطاعة والامتثال، كان مجرد كل منهما مسقطا للامرين من دون إمتثال.
وأما الامتثال للامر بهما فلا يحصل إلا مع العلم.
ثم إن هذين الامرين مع التمكن من إمتثالهما يكون المكلف مخيرا في إمتثال أيهما، بمعنى أن المكلف مخير بين تحصيل العلم بالواقع فيتعين عليه وينتفي موضوع الامر الاخر، إذ المفروض كونه ظاهريا قد أخذ في موضوعه عدم العلم بالواقع، وبين ترك تحصيل الواقع وإمتثال الامر الظاهري.
هذا مع التمكن من إمتثالهما.
وأما لو تعذر عليه إمتثال أحدهما تعين عليه إمتثال الاخر، كما لو عجز عن تحصيل العلم
بالواقع وتمكن من سلوك الطريق المقرر لكونه معلوما له، أو إنعكس الامر بأن تمكن من العلم و إنسد عليه باب سلوك الطريق المقرر لعدم العلم به، ولو عجز عنهما معا قام الظن بهما مقام العلم بهما بحكم العقل.
فترجيح الظن بسلوك الطريق المقرر على الظن بسلوك الواقع لم يعلم وجهه، بل الظن بالواقع أولى في مقام الامتثال، لما أشرنا إليه سابقا من حكم العقل والنقل بأولوية إحراز الواقع.
هذا في الطريق المجعول في عرض العلم بأن أذن في سلوكه مع التمكن من العلم.
وأما إذا نصبه بشرط العجز عن تحصيل العلم، فهو أيضا كذلك، ضرورة أن القائم مقام تحصيل العلم الموجب للاطاعة الواقعية عند تعذره هي الاطاعة الظاهرية المتوقفة على العلم بسلوك الطريق المجعول، لا على مجرد سلوكه.
والحاصل: أن سلوك الطريق المجعول مطلقا أو عند تعذر العلم في مقابل العمل بالواقع.
فكما أن العمل بالواقع مع قطع النظر عن العلم لا يوجب إمتثالا، وإنما يوجب فراغ الذمة من المأمور به واقعا لو لم يؤخذ فيه تحققه على وجه الامتثال، فكذلك سلوك الطريق المجعول مطلقا.
فكل منهما موجب لبراءة الذمة واقعا وإن لم يعلم بحصوله، بل ولو إعتقد عدم حصوله.
وأما العلم بالفراغ المعتبر في الاطاعه، فلا يتحقق في شئ منهما إلا بعد العلم أو الظن القائم مقامه.
فالحكم - بأن الظن بسلوك الطريق المجعول يوجب الظن بفراغ الذمة، بخلاف الظن بأداء الواقع، فإنه لا يوجب الظن بفراغ الذمة، إلا إذا ثبت حجية ذاك الظن وإلا فربما يظن بأداء الواقع من طريق يعلم بعدم حجيته - تحكم صرف.
ومنشأ ما ذكره، قدس سره، تخيل أن نفس سلوك الطريق الشرعي المجعول، في مقابل سلوك الطريق العقلي الغير المجعول.
وهو العلم بالواقع الذي هو سبب تام لبراءة الذمة، فيكون هو أيضا كذلك، فيكون الظن بالسلوك ظنا بالبراءة.
بخلاف الظن بالواقع، لان نفس أداء الواقع ليس سببا تاما للبراءة، حتى يحصل من الظن به الظن بالبراءة.
فقد قاس الطريق الشرعي بالطريق العقلي.
وأنت خبير بأن الطريق الشرعي لا يتصف بالطريقيه فعلا إلا بعد العلم به تفصيلا، وإلا فسلوكه، أعني مجرد تطبيق الاعمال عليه مع قطع النظرعن حكم الشارع، لغو صرف.
ولذلك أطلنا الكلام في أن سلوك الطريق المجعول في مقابل العمل بالواقع، لا في مقابل العلم بالعمل بالواقع.
ويلزم من ذلك كون كل من العلم والظن المتعلق بأحدهما في مقابل المتعلق بالاخر.
فدعوى: (أن الظن بسلوك الطريق يستلزم الظن بالفراغ، بخلاف الظن بإتيان الواقع)، فاسدة.
هذا كله، مع ما علمت سابقا في رد الوجه الاول مع إمكان منع جعل الشارع طريقا إلى الاحكام.
وإنما إقتصر على الطرق المنجعلة عند العقلاء وهو العلم ثم على الظن الاطميناني.
ثم إنك حيث عرفت أن مآل هذا القول إلى أخذ نتيجة دليل الانسداد بالنسبة إلى المسائل الاصولية وهي حجية الامارات المحتملة للحجية، لا بالنسبة إلى نفس الفروع، فاعلم أن في مقابله قولا آخر لغير واحد من مشايخنا المعاصرين، قدست أسرارهم، وهو عدم جريان دليل الانسداد على وجه يشمل مثل هذه المسألة الاصولية، أعني حجية الامارات المحتملة.
وهذا هو القول الذي ذكرنا في أول التنبيه: أنه ذهب إليه فريق.
وسيأتي الكلام فيه عند التكلم في حجية الظن المتعلق بالمسائل الاصولية إن شاء الله تعالى.
ثم إعلم: أن بعض من لا خبرة له، لما لم يفهم من دليل الانسداد إلا ما تلقن من لسان بعض مشايخه وظاهر عبارة كتاب القوانين، رد القول الذي ذكرناه أولا عن بعض المعاصرين، من حجية الظن في الطريق، لا في نفس الاحكام بمخالفته لاجماع العلماء حيث زعم أنهم بين من يعمم دليل الانسداد لجميع المسائل العلمية أصولية أو فقهية كصاحب القوانين، وبين من يخصصه بالمسائل الفرعية.
فالقول بعكس هذا خرق للاجماع المركب.
ويدفعه: أن المسألة ليست من التوقيفيات التي يدخلها الاجماع المركب، مع أن دعواه في مثل هذه المسائل المستحدثة بشيعة جدا، بل المسألة عقلية.
فإذا فرض إستقلال العقل بلزوم العمل بالظن في مسألة تعيين الطرق، فلا معنى لرده بالاجماع المركب.
فلا سبيل إلى رده إلا بمنع جريان حكم العقل وجريان مقدمات الانسداد في خصوصها، كما عرفته منا، أو فيها في ضمن مطلق الاحكام الشرعية، كما فعله غير واحد من مشايخنا.
الامر الثاني: نتيجة دليل الانسداد قضية مهملة أو كلية
وهو أهم الامور في هذا الباب، أن نتيجة دليل الانسداد: هل هي قضية مهملة من حيث أسباب الظن، فلا يعم الحكم لجميع الامارات الموجبة للظن إلا بعد ثبوت معمم، من لزوم ترجيح بلا مرجح، أو إجماع مركب، أو غير ذلك، أو قضية كلية لا تحتاج في التعميم إلى شئ؟ وعلى التقدير الاول، فهل يثبت المرجح لبعض الاسباب على بعض أم لم يثبت، وعلى التقدير الثاني، أعني كون القضية كلية، فكيف توجبه خروج القياس، مع أن الدليل العقلي لا يقبل التخصيص.
فهنا مقامات:
المقام الاول: في كون نتيجة دليل الانسداد مهملة أو معينة
والتحقيق أنه لا إشكال في أن المقدمات السابقة التي حاصلها بقاء التكليف، وعدم التمكن من العلم، وعدم وجوب الاحتياط، وعدم جواز الرجوع إلى القاعدة التي يقتضيها المقام إذا جرت في مسألة تعين وجوب العمل بأي ظن حصل في تلك المسألة من أي سبب.
وهذا الظن كالعلم في عدم الفرق في إعتباره بين الاسباب والموارد والاشخاص، وهذا ثابت بالاجماع وبالعقل.
وقد سلك هذا المسلك صاحب القوانين، حيث أنه أبطل البراءة في كل مسألة من غير ملاحظة لزوم الخروج عن الدين، وأبطل لزوم الاحتياط كذلك مع قطع النظر عن لزوم الحرج.
ويظهر أيضا من صاحبي المعالم والزبدة، بناء على إقتضاء ما ذكراه لاثبات حجية خبر الواحد للعمل بمطلق
الظن، فلاحظ.
لكنك قد عرفت مما سبق أنه لا دليل على بطلان جريان أصالة البراءة وأصالة الاحتياط و الاستصحاب المطابق لاحدهما في كل مورد مورد من مواردها بالخصوص.
إنما الممنوع جريانها في جميع المسائل، للزوم المخالفة القطعية الكثيرة ولزوم الحرج عن الاحتياط.
وهذا المقدار لا يثبت إلا وجوب العمل بالظن في الجملة، من دون تعميم بحسب الاسباب ولا بحسب الموارد ولا بحسب مرتبة الظن.
وحينئذ فنقول: إنه إما أن يقرر دليل الانسداد على وجه يكون كاشفا عن حكم الشارع بلزوم العمل بالظن، بأن يقال: إن بقاء التكاليف - مع العلم بأن الشارع لم يعذرنا في ترك التعرض لها و إهمالها، مع عدم إيجاب الاحتياط علينا وعدم بيان طريق مجعول فيها - يكشف عن أن الظن جائز العمل وأن العمل به ماض عند الشارع وأنه لا يعاقبنا على ترك واجب إذا ظن بعدم وجوبه ولا بفعل محرم إذا ظن بعدم تحريمه.
فحجية الظن على هذا التقرير تعبد شرعي كشف عنه العقل من جهة دوران الامر بين أمور كلها باطلة سواه، فالاستدلال عليه من باب الاستدلال على تعيين أحد طرفي المنفصله أو أطرافها بنفي الباقي، فيقال: أن الشارع إما أن أعرض عن هذه التكاليف المعلومة إجمالا، أو أراد الامتثال بها على العلم، أو أراد الامتثال المعلوم إجمالا، أو أراد إمتثالها من طريق خاص تعبدي، أو أراد إمتثالها الظني.
وما عدا الاخير باطل، فتعين هو.
وإما أن يقرر على وجه يكون العقل منشأ للحكم بوجوب الامتثال الظني، بمعنى حسن المعاقبة على تركه وقبح المطالبة بأزيد منه، كما يحكم بوجوب تحصيل العلم وعدم كفاية الظن عند التمكن من تحصيل العلم.
فهذا الحكم العقلي ليس من مجعولات الشارع، إذ كما أن نفس وجوب الاطاعة وحرمة المعصية بعد تحقق الامر والنهي من الشارع ليس من الاحكام المجعولة للشارع، بل شئ يستقل به العقل لا على وجه الكشف، فكذلك كيفية الاطاعة وأنه يكفي فيها الظن بتحصيل مراد الشارع في مقام ويعتبر فيها العلم بتحصيل المراد في مقام آخر إما تفصيلا أو إجمالا.
وتوهم: (أنه يلزم على هذا إنفكاك حكم العقل عن حكم الشارع)، مدفوع: بما قررنا في محله، من أن التلازم بين الحكمين إنما هو مع قابلية المورد لهما.
أما لو كان قابلا لحكم العقل دون الشرع فلا، كما في الاطاعه والمعصية، فإنهما لا يقبلان لورود حكم الشارع عليهما بالوجوب والتحريم الشرعيين بأن يريد فعل الاولى وترك الثانية بإرادة مستقلة غير إرادة فعل المأمور به وترك المنهي
عنه الحاصلة بالامر والنهي، حتى أنه لو صرح بوجوب الاطاعة وتحريم المعصية، كان الامر والنهي للارشاد لا التكليف، إذ لا يترتب على مخالفة هذا الامر والنهي إلا ما يترتب على ذات المأمور به و المنهي عنه، أعني نفس الاطاعة والمعصية.
وهذا نفس دليل الارشاد، كما في أوامر الطبيب.
ولذا لا يحسن من الحكيم عقاب آخر أو ثواب آخر غير ما يترتب على نفس المأمور به والمنهي عنه فعلا أو تركا من الثواب والعقاب.
ثم إن هذين التقريرين مشتركان في الدلالة على التعميم من حيث الموارد يعني المسائل، إذ على الاول يدعى الاجماع القطعي على أن العمل بالظن لا يفرق فيه بين أبواب الفقه، وعلى الثاني يقال إن العقل مستقل بعدم الفرق في باب الاطاعة والمعصية بين واجبات الفروع من أول الفقه إلى آخره ولا بين محرماتها كذلك، فيبقى التعميم من جهتي الاسباب ومرتبة الظن.
فنقول: أما التقرير الثاني، فهو يقتضي التعميم والكلية من حيث الاسباب، إذ العقل لا يفرق في باب الاطاعة الظنية بين أسباب الظن، بل هو من هذه الجهة نظير العلم لا يقصد منه إلا الانكشاف.
وأما من حيث مرتبة الانكشاف قوة وضعفا فلا تعميم في النتيجة، إذ لا يلزم من بطلان كلية العمل بالاصول التي هي طرق شرعية الخروج عنها بالكلية، بل يمكن الفرق في مواردها بين الظن القوي البالغ حد سكون النفس في مقابلها فيؤخذ به وبين ما دونه فيؤخذ بها.
وأما التقرير الاول، فالاهمال فيه ثابت من جهة الاسباب ومن جهة المرتبة.
إذا عرفت ذلك، فنقول: الحق في تقرير دليل الانسداد هو التقرير الثاني، وأن التقرير على جه الكشف فاسد.
أما أولا، فلان المقدمات المذكورة لا تستلزم جعل الشارع الظن، مطلقا أو بشرط حصوله من اسباب خاصة، حجة، لجواز أن لا يجعل الشارع طريقا للامتثال بعد تعذر العلم أصلا.
بل عرفت في الوجه الاول من الايراد على القول بإعتبار الظن في الطريق أن ذلك غير بعيد.
وهو أيضا طريق العقلاء في التكاليف العرفية، حيث يعملون بالظن في تكاليفهم العرفية مع القطع بعدم جعل طريق لها من جانب الموالي، ولا يجب على الموالي نصب الطريق عند تعذر العلم.
نعم يجب عليهم الرضا بحكم العقل ويقبح عليهم المؤاخذة على مخالفة الواقع الذي يؤدي إليه الامتثال الظني، إلا أن يقال: إن مجرد إمكان ذلك ما لم يحصل العلم به لا يقدح في إهمال النتيجة وإجمالها، فتأمل.
وأما ثانيا، فلانه إذا بنى على كشف المقدمات المذكورة عن جعل الظن على وجه الاهمال والاجمال صح المنع الذي اورده بعض المتعرضين لرد هذا الدليل، وقد أشرنا إلى سابقا.
وحاصله:
أنه كما يحتمل أن يكون الشارع قد جعل لنا مطلق الظن أو الظن في الجملة المتردد بين الكل والبعض المردد بين الابعاض، كذلك يحتمل أن يكون قد جعل لنا شيئا آخر حجة من دون إعتبار إفادته الظن، لانه أمر ممكن غير مستحيل.
والمفروض عدم إستقلال العقل بحكم في هذا المقام.
فمن أين يثبت جعل الشارع الظن في الجملة دون شئ آخر، ولم يكن لهذا المنع دفع أصلا، إلا أن يدعى الاجماع على عدم نصب شئ آخر غير الظن في الجملة، فتأمل.
وأما ثالثا، فلانه لو صح كون النتيجة مهملة مجملة لم ينفع أصلا إن بقيت على إجمالها، وإن عينت فإما أن تعين في ضمن كل الاسباب وإما أن تعين في ضمن بعضها المعين، وسيجئ عدم تمامية شئ من هذين إلا بضميمة الاجماع، فيرجع الامر بالاخرة إلى دعوى الاجماع على حجية مطلق الظن بعد الانسداد.
فتسميته دليلا عقليا لا يظهر له وجه عدا كون الملازمة بين تلك المقدمات الشرعية ونتيجتها عقلية.
وهذا جار في جميع الادلة السمعية، كما لا يخفى.
المقام الثاني: في أنه على أحد التقريرين السابقين هل يحكم بتعميم الظن من حيث الاسباب أو المرتبة
أم فنقول: أما على تقدير كون العقل كاشفا عن حكم الشارع بحجية الظن في الجمله، فقد عرفت أن الاهمال بحسب الاسباب وبحسب المرتبة.
ويذكر للتعميم من جهتها وجوه.
الاول [ من طرق التعميم ] عدم المرجح لبعضها على بعض فيثبت التعميم، لبطلان الترجيح بلا مرجح، والاجماع على بطلان التخيير.والتعميم بهذا الوجه يحتاج إلى ذكر ما يصلح أن يكون مرجحا وإبطاله.
وليعلم أنه لا بد أن يكون المعين والمرجح معينا لبعض كاف بحيث لا يلزم من الرجوع بعد الالتزام به إلى الاصول محذور، وإلا فوجوده لا يجدي.
إذا تمهد هذا فنقول: ما يصلح أن يكون معينا أو مرجحا أحد أمور ثلاثة:
الاول: من هذه الامور كون بعض الظنون متيقنا بالنسبة إلى الباقي، بمعنى كونه واجب العمل قطعا على كل تقدير، فيؤخذ به ويطرح الباقي، للشك في حجيته.
وبعبارة أخرى: يقتصر في القضيه المهملة المخالفة للاصل على المتيقن، وإهمال النتيجة حينئذ من حيث الكم فقط، لتردده بين الاقل المعين والاكثر.
ولا يتوهم: (أن هذا المقدار المتيقن حينئذ من الظنون الخاصة، للقطع التفصيلي بحجيته)، لاندفاعه: بأن المراد من الظن الخاص ما علم حجيته بغير دليل الانسداد، فتأمل.
الثاني: كون بعض الظنون أقوى من بعض، فتعين العمل عليه، للزوم الاقتصار في مخالفة الاحتياط اللازم في كل واحد من محتملات التكاليف الواقعية من الواجبات والمحرمات على القدر.
المتيقن.
وهو ما كان الاحتمال الموافق للاحتياط فيه في غاية البعد، فإنه كلما ضعف الاحتمال
الموافق للاحتياط كان إرتكابه أهون.
الثالث: كون بعض الظنون مظنون الحجية.
فإنه في مقام دوران الامر بينه وبين غيره يكون أولى من غيره، إما لكونه أقرب إلى الحجية من غيره، ومعلوم أن القضية المهملة المجملة تحمل، بعد صرفها إلى البعض بحكم العقل، على ما هو أقرب محتملاتها إلى الواقع، وإما لكونه أقرب إلى إحراز مصلحة الواقع، لان المفروض رجحان مطابقته للواقع، لان المفروض كونه من الامارات المفيدة للظن بالواقع ورجحان كونه بدلا عن الواقع.
لان المفروض الظن بكونه طريقا قائما مقام الواقع، بحيث يتدارك مصلحة الواقع على تقدير مخالفته له، فإحتمال مخالفة هذه الامارة للواقع ولبدله موهوم في موهوم.
بخلاف إحتمال مخالفة سائر الامارات للواقع، لانها على تقدير مخالفتها للواقع لا يظن كونها بدلا عن الواقع.
ونظير ذلك: ما لو تعلق غرض المريض بدواء تعذر الاطلاع العلمي عليه، فدار الامر بين دوائين، أحدهما يظن كونه ذلك الدواء، وعلى تقدير كونه غيره يظن كونه بدلا عنه في جميع الخواص.
والاخر يظن أنه ذلك الدواء، لكن لا يظن أنه على تقدير المخالفة بدل عنه، ومعلوم بالضرورة أن العمل بالاول أولى.
ثم إن البعض المظنون الحجية قد يعلم بالتفصيل، كما إذا ظن حجية الخبر المزكى رواته بعدل واحد او حجية الاجماع المنقول، وقد يعلم إجمالا وجوده بين أمارات.
فالعمل بهذه الامارات أرجح من غيرها الخارج من محتملات ذلك المظنون الاعتبار.
وهذا كما لو ظن عدم حجية بعض الامارات، كالاولوية والشهرة والاستقراء وفتوى الجماعة الموجبة للظن.
فإنا إذا فرضنا نتيجة دليل الانسداد مجملة مرددة بين هذه الامور وغيرها، وفرضنا الظن بعدم حجية هذه، لزم من ذلك الظن بأن الحجة في غيرها وإن كان مرددا بين أبعاض ذلك الغير، فكان الاخذ بالغير أولى من الاخذ بها، لعين ما تقدم وإن لم يكن بين أبعاض ذلك الغير مرجح، فافهم.هذه غاية ما يمكن ان يقال في ترجيح بعض الظنون على بعض.
لكن نقول: إن المسلم من هذه في الترجيح لا ينفع، والذي ينفع غير مسلم كونه مرجحا.
توضيح ذلك: هو أن (المرجح الاول) - وهو تيقن البعض بالنسبة إلى الباقي - وإن كان من المرجحات، بل لا يقال له المرجح، لكونه معلوم الحجية تفصيلا وغيره مشكوك الحجية، فيبقى تحت الاصل، لكنه لا ينفع، لقلته وعدم كفايته، لان القدر المتيقن من هذه الامارات هو الخبر الذي زكي جميع رواته بعدلين، ولم يعمل في تصحيح رجاله ولا في تمييز مشتركاته بظن أضعف نوعا من
سائر الامارات الاخر ولم يوهن لمعارضته شئ منها، وكان معمولا به عند الاصحاب كلا أو جلا، ومفيدا للظن الاطميناني بالصدور، إذ لا ريب أنه كلما إنتفى أحد هذه الامور الخمسة في خبر، احتمل كون غيره حجة دونه، فلا يكون متيقن الحجية على كل تقدير.
وأما عدم كفاية هذا الخبر لندرته فهو واضح، مع أنه لو كان بنفسه كثيرا كافيا، لكن يعلم إجمالا بوجود مخصصا كثيرة ومقيدات له في الامارات الاخر، فيكون نظير ظواهر الكتاب في عدم جواز التمسك بها مع قطع النظر عن غيرها، إلا أن يؤخذ بعد الحاجة إلى التعدي منها بما هو متيقن بالاضافة إلى ما بقي، فتأمل.
وأما (المرجح الثاني)، وهو كون بعضها أقوى ظنا من الباقي، ففيه: أن ضبط مرتبة خاصة له متعسر أو متعذر، لان القوة والضعف أضافيان، وليس تعارض القوي مع الضعيف هنا في متعلق واحد حتى يذهب الظن من الاضعف ويبقى في الامارة الاخرى.
نعم يوجد مرتبة خاصة، وهو الظن الاطميناني الملحق بالعلم حكما، بل موضوعا، لكنه نادر التحقق.
مع أن كون القوة معينة للقضية المجملة محل منع، إذ لا يستحيل أن يعتبر الشارع في حال الانسداد ظنا يكون أضعف من غيره.كما هو المشاهد في الظنون الخاصة، فإنها ليست على الاطلاق أقوى من غيرها بالبديهة.
وما تقدم في تقريب مرجحية القوة إنما هو مع كون إيجاب العمل بالظن عند إنسداد باب العلم من منشئآت العقل وأحكامه.
وأما على تقدير كشف مقدمات الانسداد - عن أن الشارع جعل الظن حجة في الجملة وتردد أمره في أنظارنا بين الكل والابعاض - فلا يلزم من كونه بعضها أقوى كونه هو المجعول حجة، لانا قد وجدنا تعبد الشارع بالظن الاضعف وطرح الاقوى في موارد كثيرة.
وأما (المرجح الثالث) - وهو الظن بإعتبار بعض فيؤخذ به لاحد الوجهين المتقدمين - ففيه، مع أن الوجه الثاني لا يفيد لزوم التقديم، بل أولويته: أن الترجيح على هذا الوجه يشبه الترجيح بالقوة والضعف، في أن مداره على الاقرب إلى الواقع.
وحينئذ فإذا فرضنا كون الظن الذي لم يظن بحجيته أقوى ظنا بمراتب من الظن الذي ظن بحجيته، فليس بناء العقلاء على ترجيح الثاني، فيرجع الامر إلى لزوم ملاحظة الموارد الخاصة وعدم وجود ضابطة كلية بحيث يوخذ بها في ترجيح الظن المظنون الاعتبار.
نعم لو فرض تساوي أبعاض الظنون دائما من حيث القوة والضعف، كان ذلك المرجح بنفسه منضبطا.
ولكن الفرض مستبعد بل مستحيل.مع أن اللازم على هذا أن لا يعمل بكل مظنون الحجية، بل بما يظن حجيته بظن قد ظن حجيته، لانه أبعد عن مخالفة الواقع وبدله بناء على
التقرير المتقدم.وأما الوجه الاول المذكور في تقريب ترجيح مظنون الاعتبار على غيره.
ففيه: أولا، أنه لا أمارة تفيد الظن بحجية أمارة على الاطلاق، فإن أكثر ما أقيم حجية الادلة من الامارات الظنية المبحوث عنها الخبر الصحيح، ومعلوم عند المنصف أن شيئا مما ذكروه لحجيته لا يوجب الظن بها على الاطلاق.
وثانيا، أنه لا دليل على إعتبار مطلق الظن في مسألة تعيين هذا الظن المجمل.
* * *
ثم أنه قد توهم غير واحد أنه ليس المراد إعتبار مطلق الظن وحجيته في مسألة تعيين القضية المهملة، وأنما المقصود ترجيح بعضها على بعض.
فقال بعضهم في توضيح لزوم الاخذ بمظنون الاعتبار، بعد الاعتراف بأنه ليس المقصود هنا إثبات حجية الظنون المظنونة الاعتبار بالامارات الظنية القائمة عليها، ليكون الاتكال في حجيتها على مجرد الظن: (إن الدليل العقلي المثبت لحجيتها هو الدليل العقلي المذكور، والحاصل من تلك الامارات الظنية هو ترجيح بعض الظنون على البعض، فيمنع ذلك من إرجاع القضية المهملة إلى الكلية، بل يقتصر في مفاد القضية المهملة على تلك الجملة.
فالظن المفروض إنما يبعث على صرف مفاد الدليل المذكور إلى ذلك وعدم صرفه إلى سائر الظنون نظرا إلى حصول القوة بالنسبة إليها، لانضمام الظن بحجيتها إلى الظن بالواقع.
فإذا قطع العقل بحجية الظن بالقضية المهملة، ثم وجد الحجية متساوية بالنظر إلى الجميع حكم بحجية الكل.
وأما إذا وجدها مختلفة وكان جملة منها أقرب إلى الحجية من الباقي نظرا إلى الظن بحجيتها دون الباقي، فلا محالة يقدم المظنون على المشكوك والمشكوك على الموهوم في مقام الحيره والجهالة، فليس الظن مثبتا لحجية ذلك الظن، وإنما هو قاض بتقديم جانب الحجية في تلك الظنون، فينصرف إليه ما قضى به الدليل المذكور.
ثم اعترض: على نفسه، بأن صرف الدليل إليها إن كان على وجه اليقين ثم ما ذكر، وإلا كان إتكالا على الظن، والحاصل أنه لا قطع لصرف الدليل إلى تلك الظنون.
ثم أجاب: بأن الاتكال ليس على الظن بحجيتها، ولا على الظن بترجيح تلك الظنون على غيرها، بل التعويل على القطع بالترجيح.
وتوضحيه: أن قضية دليل الانسداد حجية الظن على سبيل الاهمال، فيدور الامر بين القول بحجية الجمع والبعض، ثم الامر في البعض يدور بين المظنون وغيره، وقضية العقل في الدوران بين الكل والبعض هو الاقتصار على البعض أخذا بالمتيقن.
ولذا قال علماء الميزان: إن المهملة في قوة الجزئية: ولو لم يتعين البعض في المقام ودارت الحجية بينه وبين سائر الابعاض من غير تفاوت في نظر العقل، لزم الحكم بحجية الكل، لبطلان الترجيح من غير مرجح، وأما لو كانت حجية البعض مما فيه الكفاية مظنونة بخصوصه بخلاف الباقي، كان ذلك أقرب إلى الحجية من غيره مما لم يقم على حجيته دليل.فيتعين عند العقل الاخذ به دون غيره، فإن الرجحان حينئذ قطعي وجداني.
والترجيح من جهته ليس ترجيحا بمرجح ظني، وإن كان ظنا بحجية تلك الظنون.
فإن كون المرجح ظنيا لا يقتضي كون الترجيح ظنيا، وهو ظاهر)، إنتهى كلامه، رفع مقامه.
أقول: قد عرفت سابقا أن مقدمات دليل الانسداد، إما أن تجعل كاشفة عن كون الظن في الجملة حجة علينا بحكم الشارع، كما يشعر به قوله: (كان بعض الظنون أقرب إلى الحجية من الباقي)، وإما أن تجعل منشأ لحكم العقل بتعيين إطاعة الله سبحانه حين الانسداد على وجه الظن، كما يشعر به قوله نظرا إلى حصول القوة لتلك الجملة، لانضمام الظن بحجيتها إلى الظن بالواقع.
فعلى الاول، إذا كان الظن المذكور مرددا بين الكل والبعض اقتصر على البعض، كما ذكره، لانه القدر المتيقن.
وأما إذا تردد ذلك البعض بين الابعاض، فالمعين لاحد المحتملين او المحتملات لا يكون إلا بما يقطع بحجيته، كما أنه إذا احتمل في الواقعة الوجوب والحرمة لا يمكن ترجيح أحدهما بمجرد الظن به، إلا بعد إثبات حجية ذلك الظن.
بل التحقيق: أن المرجح لاحد الدليلين عند التعارض كالمعين لاحد الاحتمالين يتوقف على القطع بإعتباره عقلا أو نقلا، وإلا فأصالة عدم إعتبار الظن لا فرق في مجراها بين جعلهإ دليلا وجعله مرجحا.
هذا مع أن الظن المفروض إنما قام على حجية بعض الظنون في الواقعه من حيث الخصوص،
لا على تعيين الثابت حجيته بدليل الانسداد، فتأمل.
وأما على الثاني، فالعقل إنما يحكم بوجوب الاطاعة على الوجه الاقرب إلى الواقع.
فإذا فرضنا أن مشكوك الاعتبار يحصل منه ظن بالواقع أقوى مما يحصل من الظن المظنون الاعتبار كان الاول أولى بالحجية في نظر العقل.
ولذا قال صاحب المعالم: (إن العقل قاض بأن الظن إذا كان له جهات متعددة متفاوتة بالقوة والضعف، فالعدول عن القوي منها إلى الضعيف قبيح)، إنتهى.
نعم لو كان قيام الظن على حجية بعضها مما يوجب قوتها في نظر العقل، لانها جامعة لادراك الواقع أو بدله على سبيل الظن بخلافه، رجع الترجيح به إلى ما ذكرنا سابقا وذكرنا ما فيه.
وحاصل الكلام يرجع إلى أن الظن بالاعتبار إنما يكون صارفا للقضيه إلى ما قام عليه من الظنون إذا حصل القطع بحجيته في تعيين الاحتمالات أو صار موجبا لكون الاطاعة بمقتضاها أتم، لجمعها بين الظن بالواقع والظن بالبدل.
والاول موقوف على حجية مطلق الظن.
والثاني لا إطراد له، لانه قد يعارضها قوة المشكوك الاعتبار.
وربما إلتزم بالاول بعض من أنكر حجية مطلق الظن، وأورده إلزاما على القائلين بمطلق الظن، فقال كما يقولون: (يجب علينا في كل واقعة البناء على حكم، ولعدم كونه معلوما لنا يجب في تعيينه العمل بالظن، فكذا نقول، بعد ما وجب علينا العمل بالظن ولن نعلم تعيينه: يجب علينا في تعيين هذا الظن العمل بالظن).
ثم إعترض على نفسه، بما حاصله: (إن وجوب العمل بمظنون الحجية لا ينفي غيره.
- فقال: - قلنا: نعم، ولكن لا يكون حينئذ دليل على حجية ظن آخر، إذ بعد ثبوت حجية الظن المظنون الحجية ينفتح باب الاحكام ولا يجري دليلك فيه ويبقى تحت أصالة عدم الحجية).
وفيه: أنه إذا التزم، بإقتضاء مقدمات الانسداد مع فرض عدم المرجح، العمل بمطلق الظن في الفروغ دخل الظن المشكوك الاعتبار وموهومه، فلا مورد للترجيح والتعيين حتى يعين بمطلق
الظن لان الحاجة إلى التعيين بمطلق الظن فرع عدم العمل بمطلق الظن.
وبعبارة أخرى: إما أن يكون مطلق الظن حجة وإما لا.
فعلى الاول لا مورد للتعيين والترجيح، وعلى الثاني لا يجوز الترجيح بمطلق الظن.
فالترجيح بمطلق الظن ساقط على كل تقدير.
وليس للمعترض القلب بأنه إن ثبت حجية مطلق الظن تعين ترجيح مظنون الاعتبار به، إذ على تقدير ثبوت حجية مطلق الظن لا تعقل ترجيح حتى يتعين الترجيح بمطلق الظن.
ثم إن لهذا المعترض كلاما في ترجيح مظنون الاعتبار بمطلق الظن - لا من حيث حجية مطلق الظن حتى يقال: إن بعد ثبوتها لا مورد للترجيح - لا بأس بالاشارة إليه وإلى ما وقع من الخلط والغفلة منه في المراد بالترجيح هنا.
فقال، معترضا على القائل بما قدمنا، من أن ترجيح أحد المحتملين عين تعيينه بالاستدلال، بقوله: (إن هذا القائل خلط بين ترجيح الشئ وتعيينه ولم يعرف الفرق بينهما.
ولبيان هذا المطلب نقدم مقدمة، ثم نجيب عن كلامه، وهي أنه لا ريب في بطلان الترجيح بلا مرجح، فإنه مما يحكم بقبحه العقل والعرف والعادة، بل يقولون بإمتناعه الذاتي كالترجح بلا مرجح.
والمراد بالترجيح بلا مرجح هو سكون النفس إلى أحد الطرفين والميل إليه من غير مرجح وإن لم يحكم بتعيينه وجوبا.وأما الحكم بذلك فهو أمر آخر وراء ذلك.
ثم أوضح ذلك بأمثلة: منها أنه لو دار أمر العبد في أحكام السلطان المرسلة إليه بين أمور وكان بعضها مظنونا بظن لم يعلم حجيته من طرف السلطان، صح له ترجيح المظنون ولا يجوز له الحكم بلزوم ذلك.
ومنها أنه لو أقدم على أحد طعامان أحدهما ألذ من الاخر فاختاره عليه لم يرتكب ترجيحا بلا مرجح، وإن لم يلزم أكل الالذ، ولكن لو حكم بلزوم الاكل لا بد من تحقق دليل عليه، ولا يكفي مجرد الالذيه.
نعم لو كان أحدهما مضرا صح الحكم باللزوم.
ثم قال: وبالجملة، فالحكم بلا دليل غير الترجيح بلا مرجح، فالمرجح غير الدليل، والاول يكون في مقام الميل والعمل، والثاني يكون في مقام التصديق والحكم.
ثم قال: أن ليس المراد أنه يجب العمل بالظن المظنون حجيته وانه الذي يجب العمل به بعد إنسداد باب العلم.
بل مراده أنه - بعد ما وجب على المكلف،
لانسداد باب العلم وبقاء التكليف، العمل بالظن، ولا يعلم أي ظن لو عمل بالظن المظنون حجيته - أي نقض يلزم عليه.
فإن قلت: ترجيح بلا مرجح فقد غلطت غلطا ظاهرا، وإن كان غيره، فبينه حتى ننظر)، إنتهى كلامه.
أقول: لا يخفى أنه ليس المراد من أصل دليل الانسداد إلا وجوب العمل بالظن، فإذا فرض أن هذا الواجب تردد بين ظنون، فلا غرض إلا في تعيينه، بحيث يحكم بأن هذا هو الذي يجب العمل به شرعا، حتى يبني المجتهد عليه في مقام العمل ويلتزم بمؤداه على أنه حكم شرعي عزمي من الشارع.
وأما دواعي إرتكاب بعض الظنون دون بعض فهي مختلفة غير منضبطة: فقد يكون الداعي إلى الاختيار موجودا في موهوم الاعتبار لغرض من الاغراض، وقد يكون في مظنون الاعتبار.
فليس الكلام إلا في أن الظن بحجية بعض الظنون هل يوجب الاخذ بتلك الظنون شرعا، بحيث يكون الآخذ بغيره لداع من الدواعي معاقبا عند الله في ترك ما هو وظيفته من سلوك الطريق.
وبعبارة أخرى: هل يجوز شرعا أن يعمل المجتهد بغير مظنون الاعتبار أم لا يجوز؟ إن قلت: لا يجوز شرعا.
قلنا: فما الدليل الشرعي بعد جواز العمل بالظن في الجملة على أن تلك المهملة غير هذه الجزئية.
وإن قلت: يجوز، لكن بدل عن مظنون الاعتبار، لا جمعا بينهما، فهذا هو التخيير الذي التزم المعمم ببطلانه.
وإن قلت: يجوز جمعا بينهما فهذا هو مطلب المعمم.
فليس المراد بالمرجح ما يكون داعيا إلى إرادة أحد الطرفين، بل المراد ما يكون دليلا على حكم الشارع.
ومن المعلوم أن هذا الحكم الوجوبي لا يكون إلا عن حجة شرعية، فلو كان هي مجرد الظن بوجوب العمل بذلك البعض، فقد لزم العمل بمطلق الظن عند إشتباه الحكم الشرعي.
فإذا جاز ذلك في هذا المقام لم لا يجوز في سائر المقامات؟ فلم قلتم إن نتيجة دليل الانسداد حجية الظن في الجملة؟ وبعبارة أخرى: لو إقتضى إنسداد باب العلم في الاحكام تعيين الاحكام المجهولة بمطلق الظن، فلم منعتم إفادة ذلك الدليل إلا لاثبات حجية الظن في الجملة، وإن إقتضى تعيين الاحكام بالظن في الجملة لم يوجب إنسداد باب العلم في تعيين الظن في الجملة الذي وجب العمل به بمقتضى الانسداد العمل في تعيينه بمطلق الظن.
وحاصل الكلام: أن المراد من المرجح هنا هو المعين والدليل الملزم من جانب الشارع ليس إلا.
فإن كان في المقام شئ غير الظن فليذكر، وإن كان مجرد الظن فلم تثبت حجية مطلق الظن.
فثبت من جميع ذلك أن الكلام ليس في المرجح للفعل، بل المطلوب المرجح للحكم بأن الشارع أوجب بعد الانسداد العمل بهذا دون ذلك.
ومما ذكرنا: يظهر ما في آخر كلام البعض المتقدم ذكره في توضيح مطلبه، من أن كون المرجح ظنيا لا يقتضي كون الترجيح ظنيا.
فإنا نقول: إن كون المرجح قطعيا لا يقتضي ذلك، بل إن قام دليل على إعتبار ذلك المرجح شرعا كان الترجيح به قطعيا، وإلا فليس ظنيا أيضا.
ثم إن ما ذكره الاخير في مقدمته، من أن الترجيح بلا مرجح قبيح، بل محال، يظهر منه خلط بين الترجيح بلا مرجح في الايجاد والتكوين وبينه في مقام الالزام والتكليف.فإن الاول محال، لا قبيح، والثاني قبيح، لا محال.
فالاضراب في كلامه عن القبيح إلى الاستحالة لا مورد له، فافهم.
فثبت مما ذكرنا أن تعيين الظن في الجملة من بين الظنون بالظن غير مستقيم.
وفي حكمه ما لو عين بعض الظنون لاجل الظن بعدم حجية ما سواه، كالاولوية والاستقراء بل الشهره، حيث أن المشهور على عدم إعتبارها، بل لا يبعد دخول الاولين تحت القياس المنهي عنه، بل النهي عن العمل بالاولى منهما وارد في قضية (أبان) المتضمنة لحكم دية أصابع المرأة.
فإنه يظن بذلك أن الظن المعتبر بحكم الانسداد في ما عدا هذه الثلاثة.
وقد ظهر ضعف ذلك مما ذكرنا من عدم إستقامة تعيين القضية المهملة بالظن.
ونزيد هنا أن دعوى حصول الظن على عدم إعتبار هذه الامور ممنوعة، لان مستند الشهرة على عدم إعتبارها ليس إلا عدم الدليل عند المشهور على إعتبارها، فيبقى تحت الاصل، لا لكونها منهيا عنها بالخصوص، كالقياس.
ومثل هذه الشهرة المستندة إلى الاصل لا يوجب الظن بالواقع.
وأما دعوى كون الاولين قياسا، فنكذبه بعمل غير واحد من أصحابنا عليهما.
بل الاولوية قد عمل بها غير واحد من أهل الظنون الخاصة في بعض الموارد.
ومنه يظهر الوهن في دلالة قضية (أبان) على حرمة العمل عليها بالخصوص، فلا يبقى ظن من الرواية بحرمة العمل عليها بالخصوص.
ولو فرض ذلك دخل الاولوية في ما قام الدليل على عدم إعتباره، لان الظن الحاصل من رواية أبان متيقن الاعتبار بالنسبة إلى الاولوية، فحجيتها مع عدم حجية الخبر الدال على المنع عنها غير محتملة، فتأمل.
ثم بعدما عرفت من عدم إستقامة تعيين القضية المهملة بمطلق الظن، فاعلم: أنه قد يصح تعيينها بالظن في مواضع: أحدها: أن يكون الظن القائم على حجية بعض الظنون من المتيقن إعتباره بعد الانسداد، إما مطلقا، كما إذا قام فرد من الخبر الصحيح المتيقن إعتباره من بين سائر الاخبار وسائر الامارات على حجية بعض ما دونه، فإنه يصير حينئذ متيقن الاعتبار، لاجل قيام الظن المتيقن الاعتبار على إعتباره، وإما بالاضافة إلى ما قام على إعتباره إذا ثبت حجية ذلك الظن القائم.
كما لو قام الاجماع المنقول على حجية الاستقراء مثلا، فإنه يصير بعد إثبات حجية الاجماع المنقول على بعض الوجوه ظنا معتبرا.
ويلحق به ما هو متيقن بالنسبة إليه كالشهرة، إذا كانت متيقنة الاعتبار بالنسبة إلى الاستقراء بحيث لا يحتمل إعتباره دونها.
لكن هذا مبني على عدم الفرق في حجية الظن بين كونه في المسائل الفروعية وكونه في المسائل الاصولية، وإلا فلو قلنا إن الظن في الجملة، الذي قضى به مقدمات دليل الانسداد، إنما هو المتعلق بالمسائل الفرعية دون غيرها، فالقدر المتيقن إنما هو متيقن بالنسبة إلى الفروع، لا غير.
وما ذكرنا سابقا، من عدم الفرق بين تعلق الظن بنفس الحكم الفرعي وبين تعلقه بما جعل طريقا إليه، إنما هو بناء على ما هو التحقيق من تقرير مقدمات الانسداد على وجه يوجب حكومة العقل دون كشفه عن جعل الشارع، والقدر المتيقن مبني على الكشف، كما سيجئ.إلا أن يدعى أن القدر المتيقن في الفروع هو متيقن في المسائل الاصولية أيضا.
الثاني: أن يكون الظن القائم على حجية ظن متحدا لا تعدد فيه، كما إذا كان مظنون الاعتبار منحصرا فيما قام أمارة واحدة على حجيته، فإنه يعمل به في تعيين المتبع وإن كان أضعف الظنون، لانه إذا إنسد باب العلم في مسألة تعيين ما هو المتبع بعد الانسداد ولم يجز الرجوع فيها إلى الاصول حتى الاحتياط، كما سيجئ، تعين الرجوع إلى الظن الموجود في المسألة، فيؤخذ به، لما عرفت من أن كل مسألة إنسد فيها باب العلم وفرض عدم صحة الرجوع فيها إلى مقتضى الاصول، تعين بحكم العقل العمل بأي ظن وجد في تلك المسألة.
الثالث: أن يتعدد الظنون في مسألة تعيين المتبع بعد الانسداد بحيث يقوم كل واحد منها على إعتبار طائفة من الامارات كافية في الفقه.
لكن يكون هذه الظنون القائمة كلها في مرتبة لا يكون إعتبار بعضها مضنونا.
فحينئذ إذا وجب بحكم مقدمات الانسداد في مسألة تعيين المتبع الرجوع فيها إلى الظن في الجملة، والمفروض تساوي الظنون الموجودة في تلك المسألة وعدم المرجح لبعضها،
وجب الاخذ بالكل بعد بطلان التخيير بالاجماع وتعسر ضبط البعض الذي لا يلزم العسر من الاحتياط فيه.
ثم على تقدير صحة تقرير الانسداد على وجه الكشف، فالذي ينبغي أن يقال: أن اللازم على هذا، أولا، هو الاقتصار على المتيقن من الظنون.
وهل يلحق به كل ما قام المتيقن على إعتباره؟ وجهان، أقواهما العدم، كما تقدم، إذ بناء على هذا التقرير لا نسلم كشف العقل بواسطة مقدمات الانسداد إلا عن إعتبار الظن في الجملة في الفروع دون الاصول، والظن بحجية الامارة الفلانية ظن بالمسألة الاصولية.
نعم مقتضى تقرير الدليل على وجه حكومة العقل أنه لا فرق بين تعلق الظن بالحكم الفرعي أو بحجية طريق.
ثم إن كان القدر المتيقن كافيا في الفقه، بمعنى أنه لا يلزم من العمل بالاصول في مجاريها المحذور اللازم على تقدير الاقتصار على المعلومات، فهو، وإلا فالواجب الاخذ بما هو المتيقن من الامارات الباقية الثابتة بالنسبة إلى غيرها.
فإن كفى في الفقه بالمعنى الذي ذكرنا فهو، وإلا فيؤخذ بما هو المتيقن بالنسبة، وهكذا.
ثم لو فرضنا عدم القدر المتيقن بين الامارات أو عدم كفاية ما هو القدر المتيقن مطلقا أو بالنسبة: فإن لم يكن على شئ منها أمارة، فاللازم الاخذ بالكل، لبطلان التخيير بالاجماع وبطلان طرح الكل بالفرض وفقد المرجح، فتعين الجمع.
وإن قام على بعضها أمارة: فإن كانت أمارة واحدة، كما إذا قامت الشهرة على حجية جملة من الامارات، كان اللازم الاخذ بها، لتعيين الرجوع إلى الشهرة في تعيين المتبع من بين الظنون، وإن كانت امارات متعددة قامت كل واحدة منها على حجية ظن مع الحاجة إلى جميع تلك الظنون في الفقه وعدم كفاية بعضها عمل بها.
ولا فرق حينئذ بين تساوي تلك الامارات القائمة من حيث الظن بالاعتبار والعدم وبين تفارتها في ذلك.
وأما لو قامت كل واحدة منها على مقدار من الامارات كاف في الفقه: فإن لم تتفاوت الامارات القائمة في الظن بالاعتبار وجب الاخذ بالكل، كالامارة الواحدة لفقد المرجح، وإن تفاوتت: فما قام متيقن أو مظنون الاعتبار على إعتباره يصير معينا لغيره، كما إذا قام الاجماع المنقول بناء على كونه مظنون الاعتبار على حجية أمارة غير مظنون الاعتبار وقامت تلك الامارة، فإنها تتعين بذلك.
هذا كله على تقدير كون دليل الانسداد كاشفا.
وأما، على ما هو المختار من كونه حاكما، فسيجئ الكلام فيه بعد الفراغ عن المعممات التى ذكروها لتعميم النتيجة، إن شاء الله تعالى.
إذا عرفت ذلك، فاللازم على المجتهد أن يتأمل في الامارات، حتى يعرف المتيقن منها حقيقة أو بالاضافة إلى غيرها، ويحصل ما يمكن تحصيله من الامارات القائمة على حجية تلك الامارات، ويميز بين تلك الامارات القائمة من حيث التساوي والتفاوت من حيث الظن بحجية بعضها من أمارة أخرى، ويعرف كفاية ما أحرز إعتباره من تلك الامارات وعدم كفايته في الفقه.
وهذا يحتاج إلى سير مسائل الفقه إجمالا حتى يعرف أن القدر المتيقن من الاخبار، مثلا، لا يكفي في الفقه بحيث يرجع، في موارد خلت عن هذا الخبر، إلى الاصول التي يقتضيها الجهل بالحكم في ذلك المورد.
فأنه إذا إنضم إليه قسم آخر من الخبر، لكونه متيقنا إضافيا، أو لكونه مظنون الاعتبار بظن متبع، هل يكفي أم لا؟ فليس له الفتوى على وجه يوجب طرح سائر الظنون حتى يعرف كفاية ما أحرزه من جهة اليقين أو الظن المتبع.
وفقنا الله للاجتهاد الذي هو أشد من طول الجهاد، بحق محمد وآله الامجاد.
الثاني من طرق التعميم ما سلكه غير واحد من المعاصرين من عدم الكفاية حيث إعترفوا - بعد تقسيم الظنون إلى مظنون الاعتبار ومشكوكه - وموهومه بأن مقتضى القاعدة بعد إهمال النتيجة الاقتصار على مظنون الاعتبار، ثم على المشكوك، ثم يتسرى إلى الموهوم.
لكن الظنون المظنونة الاعتبار غير كافية، إما بأنفسها، بناء على إنحصارها في الاخبار الصحيحة بتزكية عدلين، وإما لاجل العلم الاجمالي بمخالفة كثير من ظواهرها للمعانى الظاهرة منها ووجود ما يظن منه ذلك في الظنون المشكوكة الاعتبار.
فلا يجوز التمسك بتلك الظواهر، للعلم الاجمالي المذكور، فيكون حالها حال ظاهر الكتاب والسنة المتواترة في عدم الوفاء بمعظم الاحكام.
فلا بد من التسري، بمقتضى قاعدة الانسداد ولزوم المحذور من الرجوع إلى الاصول، إلى الظنون المشكوكة الاعتبار التي دلت على إرادة خلاف الظاهر في ظواهر مظنون الاعتبار، فيعمل بما هو من مشكوك الاعتبار مخصص لعمومات مظنون الاعتبار ومقيد لاطلاقاته وقرائن لمجازاته.
فإذا وجب العلم بهذه الطائفة من مشكوك الاعتبار، ثبت وجوب العمل لغيرها مما ليس فيها معارضة لظواهر الامارات المظنونة الاعتبار، بالاجماع على عدم الفرق بين أفراد مشكوك
الاعتبار.
فإن أحدا لم يفرق بين الخبر الحسن المعارض لاطلاق الصحيح وبين خبر حسن آخر غير معارض لخبر صحيح، بل بالاولوية القطعية.
لانه إذا وجب العمل بمشكوك الاعتبار الذي له معارضة لظاهر مظنون الاعتبار، فالعمل بما ليس له معارض أولى.
ثم نقول: إن في ظواهر مشكوك الاعتبار موارد كثيرة تعلم إجمالا بعدم إرادة المعاني الظاهرة، والكاشف عن ذلك ظنا هي الامارات الموهومة الاعتبار، فنعملا بتلك الامارات، ثم نعمل بباقي أفراد الموهوم الاعتبار بالاجماع المركب.
حيث أن أحدا لم يفرق بين الشهره المعارضة للخبر الحسن بالعموم والخصوص وبين غير المعارض له، بل بالاولوية، كما عرفت.
أقول: الانصاف: أن التعميم بهذا الطريق أضعف من التخصيص بمظنون الاعتبار، لان هذا المعمم قد جمع ضعف القولين، حيث إعترف بأن مقتضى القاعدة، لولا عدم الكفاية، الاقتصار على مظنون الاعتبار.
وقد عرفت أنه لا دليل على إعتبار مطلق الظن بالاعتبار إلا إذا ثبت جواز العمل بمطلق الظن عند إنسداد باب العلم.
وأما ما ذكره من التعميم لعدم الكفاية.
ففيه: أولا، أنه مبني على زعم كون مظنون الاعتبار منحصرا في الخبر الصحيح بتزكية عدلين.
وليس كذلك، بل الامارات الظنية من الشهرة ومنا دل على إعتبار قول الثقة، مضافا إلى ما استفيد من سيرة القدماء في العمل بما يوجب سكون النفس من الروايات وفي تشخيص أحوال الرواة، توجب الظن القوي بحجية الخبر الصحيح بتزكية عدل واحد، والخبر الموثق، والضعيف المنجبر بالشهرة من حيث الرواية.
ومن المعلوم كفاية ذلك وعدم لزوم محذور من الرجوع في موارد فقد تلك الامارات إلى الاصول.
وثانيا، أن العلم الاجمالي الذي إدعاه يرجع حاصله إلى العلم بمطابقة بعض مشكوكات الاعتبار للواقع من جهة كشفها عن المرادات في مظنونات الاعتبار.
ومن المعلوم أن العمل بها لاجل ذلك لا يوجب التعدي إلى ما ليس فيه هذه العلة، أعني مشكوكات الاعتبار الغير الكاشفة عن مرادات مظنونات الاعتبار، فإن العلم الاجمالي بوجود شهرات متعددة مقيدة لاطلاقات الاخبار أو مخصصة لعموماتها لا يوجب التعدي إلى الشهرات الغير المزاحمة للاخبار بتقييد أو تخصيص، فضلا عن التسري إلى الاستقراء والاولوية.
ودعوى الاجماع لا يخفى ما فيها، لان الحكم بالحجية في القسم الاول لعلة غير مطردة في القسم الثاني حكم عقلي.
فعلم بعدم تعرض الامام - عليه السلام - له قولا ولا فعلا، إلا من باب تقرير
حكم العقل.
والمفروض عدم جريان حكم العقل في غير مورد العلة، وهي وجود العلم الاجمالي.
ومن ذلك: يعرف الكلام في دعوى الاولوية، فإن المناط في العمل بالقسم الاول إذا كان هو العمل الاجمالي، فكيف يتعدى إلى ما لا يوجد فيه المناط فضلا عن كونه أولى.
وكأن متوهم الاجماع رأى أن أحدا من العلماء لم يفرق بين أفراد الخبر الحسن أو أفراد الشهرة، ولم يعلم أن الوجه عندهم ثبوت الدليل عليهما مطلقا أو نفيه كذلك، لانهم أهل الظنون الخاصة، بل لو ادعى الاجماع - على أن كل من عمل بجملة من الاخبار الحسان أو الشهرات لاجل العلم الاجمالي بمطابقة بعضها للواقع، لم يعمل بالباقي الخالي عن هذا العلم الاجمالي - كان في محله.
الثالث من طرق التعميم ما ذكره بعض مشايخنا، طاب ثراه، من قاعدة الاشتغال بناء على أن الثابت من دليل الانسداد العمل بالظن في الجملة.
فإذا لم يكن قدر متيقن كاف في الفقه وجب العمل بكل ظن.
ومنع جريان قاعدة الاشتغال هنا - لكون ما عدا واجب العمل من الظنون محرم العمل - فقد عرفت الجواب عنه في بعض أجوبة الدليل الاول من أدلة إعتبار الظن بالطريق.
ولكن فيه: أن قاعدة الاشتغال في مسألة العمل بالظن معارضة في بعض الموارد بقاعدة الاشتغال في المسألة الفرعية.
كما إذا اقتضي الاحتياط في الفروع وجوب السورة، وكان ظن مشكوك الاعتبار على عدم وجوبها، فإنه يجب مراعاة قاعدة الاحتياط في الفروع وقراءة السورة لاحتمال وجوبها.
ولا ينافيه الاحتياط في المسألة الاصولية، لان الحكم الاصولي المعلوم بالاجمال - وهو وجوب العمل بالظن القائم على عدم الوجوب - معناه وجوب العمل على وجه ينطبق مع عدم الوجوب.ويكفي فيه أنه يقع الفعل لا على وجه الوجوب.ولاتنافي بين الاحتياط بفعل السورة لاحتمال الوجوب وكونه لا على وجه الوجوب الواقعي.
وتوضيح ذلك: أن معنى وجوب العمل بالظن وجوب تطبيق عمله عليه.
فإذا فرضنا أنه يدل على عدم وجوب شئ، فليس معنى وجوب العمل به إلا أنه لا يتعين عليه ذلك الفعل.
فإذا إختار فعل ذلك فيجب أن يقع الفعل لا على وجه الوجوب، كما لو لم يكن هذا الظن وكان غير واجب بمقتضى الاصل.
لا أنه يجب أن يقع على وجه عدم الوجوب، إذ لا يعتبر في الافعال الغير الواجبة قصد عدم الوجوب.
نعم يجب التشرع والتدين بعدم الوجوب، سواء فعله أو
تركه من باب وجوب التدين بجميع ما علم من الشرع.
وحينئذ فإذا تردد الظن الواجب العمل المذكور بين ظنون تعلقت بعدم وجوب أمور، فمعنى وجوب ملاحظة ذلك الظن المجمل المعلوم إجمالا وجوبه أن لا يكون فعله لهذه الامور على وجه الوجوب.
كما لو لم يكن هذه الظنون وكان هذه الامور مباحة بحكم الاصل ولذا يستحب الاحتياط وإتيان الفعل، لاحتمال أنه واجب.
ثم إذا فرض العلم الاجمالي من الخارج بوجوب أحد هذه الاشياء على وجه يجب الاحتياط والجمع بين تلك الامور.
فيجب على المكلف الالتزام بفعل كل واحد منها لاحتمال أن يكون هو الواجب.
وما اقتضاه الظن القائم على عدم وجوبه من وجوب أن يكون فعله لا على وجه الوجوب باق بحاله.
لان الاحتياط في الجميع لا يقتضي إتيان كل منها بعنوان الوجوب الواقعي، بل بعنوان أنه محتمل الوجوب.
والظن القائم على عدم وجوبه لا يمنع من لزوم إتيانه على الوجه.
كما أنه لو فرضنا ظنا معتبرا معلوما بالتفصيل، كظاهر الكتاب، دل على عدم وجوب شئ لم يناف مؤداه لاستحباب الاتيان بهذا الشئ لاحتمال الوجوب، هذا.
وأما ما قرع سمعك - من تقديم قاعدة الاحتياط في المسألة الاصولية على الاحتياط في المسألة الفرعية أو تعارضهما - فليس في مثل المقام.
بل مثال الاول منهما ما إذا كان العمل بالاحتياط في المسألة الاصولية مزيل للشك الموجب للاحتياط في المسألة الفرعية.
كما إذا تردد الواجب بين القصر والاتمام ودل على أحدهما أمارة من الامارات التي يعلم إجمالا بوجوب العمل ببعضها، فإنه إذا قلنا بوجوب العمل بهذه الامارات يصير حجة معينة لاحدى الصلاتين.
إلا أن الاحتياط في المسألة الاصولية إنما يقتضي إتيانها لا نفي غيرها.
فالصلاة الاخرى حكمها حكم السورة في عدم جواز إتيانها على وجه الوجوب.
فلا تنافي وجوب إتيانها، لاحتمال الوجوب، فيصير نظير ما نحن فيه.
وأما الثاني، وهو مورد المعارضة - فهو كما إذا علمنا إجمالا بحرمة شئ من بين أشياء، ودلت على وجوب كل منها أمارات نعلم إجمالا بحجية إحداهما، فإن مقتضى هذا وجوب الاتيان بالجميع، ومقتضى ذلك ترك الجميع، فافهم.
وأما دعوى (أنه إذا ثبت وجوب العمل بكل ظن في مقابل غير الاحتياط من الاصول وجب العمل به في مقابل الاحتياط للاجماع المركب)، فقد عرفت شناعته.
فإن قلت: إذا عملنا في مقابل الاحتياط بكل ظن يقتضي التكليف وعملنا في مورد الاحتياط
بالاحتياط لزم العسر والحرج، إذ يجمع حينئذ بين كل مظنون الوجوب وكل مشكوك الوجوب أو موهوم الوجوب مع كونه مطابقا للاحتياط اللازم.
فإذا فرض لزوم العسر من مراعاة الاحتياطين معا في الفقه تعين دفعه بعدم وجوب الاحتياط في مقابل الظن.
فإذا فرض هذا الظن مجملا لزم العمل بكل ظن مما يقتضي الظن بالتكليف إحتياطا.
وأما الظنون المخالفة للاحتياط اللازم فيعمل بها فرارا عن لزوم العسر.
قلت: دفع العسر يمكن بالعمل ببعضها، فما المعمم؟ فيرجع الامر إلى أن قاعدة الاشتغال لا ينفع ولا يثمر في الظنون المخالفة للاحتياط، لانك عرفت أنه لا يثبت وجوب التسري إليها فضلا عن التعميم فيها، لان التسري إليها كان للزوم العسر، فافهم.
هذا كله على تقدير تقرير مقدمات دليل الانسداد على وجه يكشف عن حكم الشارع بوجوب العمل بالظن في الجملة.
وقد عرفت أن التحقيق خلاف هذا التقرير، وعرفت أيضا ما ينبغي سلوكه على تقدير تماميته من وجوب إعتبار المتيقن حقيقة أو بالاضافة، ثم ملاحظة مظنون الاعتبار بالتفصيل الذي تقدم في آخر المعمم من المعممات الثلاثة.
وأما على تقدير تقريرها على وجه يوجب حكومة العقل - بوجوب الاطاعة الظنية والفرار عن المخالفة الظنية وأنه يقبح من الشارع تعالى إرادة أزيد من ذلك - كما يقبح من المكلف الاكتفاء بما دون ذلك - فالتعميم وعدمه لا يتصور بالنسبة إلى الاسباب، لاستقلال العقل بعدم الفرق فيما إذا كان المقصود الانكشاف الظني بين الاسباب المحصلة له.
كما لا فرق فيما إذا كان المقصود الانكشاف الجزمي بين أسبابه.
وإنما يتصور من حيث مرتبة الظن ووجوب الاقتصار على الظن القوي الذي يرتفع معه التحير عرفا.
بيان ذلك: أن الثابت من مقدمتي بقاء التكليف وعدم التمكن من العلم التفصيلي هو وجوب الامتثال الاجمالي بالاحتياط في إتيان كل ما يحتمل الوجوب وترك كل ما يحتمل الحرمة.
لكن المقدمة الثالثة النافية للاحتياط إنما أبطلت وجوبه على وجه الموجبة الكلية بأن يحتاط في كل واقعة قابلة للاحتياط او يرجع إلى الاصل كذلك.ومن المعلوم أن إبطال الموجبة الكلية لا يستلزم صدق السالبة الكلية.
وحينئذ فلا يثبت من ذلك إلا وجوب العمل بالظن على خلاف الاحتياط والاصول في الجملة.
ثم إن العقل حاكم بأن الظن القوي الاطميناني أقرب إلى العلم عند تعذره، وأنه إذا لم يمكن القطع بإطاعة مراد الشارع وترك ما يكرهه وجب تحصيل ذلك بالظن الاقرب إلى العلم.
وحينئذ فكل واقعة تقتضي الاحتياط الخاص بنفس المسألة أو الاحتياط العام من جهة كونها إحدى المسائل التي يقطع بتحقق التكليف فيها إن قام على خلاف مقتضى الاحتياط أمارة ظنية توجب الاطمينان بمطابقة الواقع، تركنا الاحتياط وأخذنا بها.
وكل واقعة ليست فيها أمارة كذلك نعمل فيها بالاحتياط، سواء لم يوجد أمارة أصلا كالوقائع المشكوكة أو كانت ولم تبلغ مرتبة الاطمينان.
وكل واقعة لم يمكن فيها الاحتياط تعين التخيير في الاول والعمل بالظن في الثاني وإن كان في غاية الضعف، لان الموافقه الظنية أولى من غيرها.والمفروض عدم جريان البراءة والاستصحاب، لانتقاضهما بالعلم الاجمالي.
فلم يبق من الاصول إلا التخيير، ومحله عدم رجحان أحد الاحتمالين، وإلا فيؤخذ بالراجح.
ونتيجة هذا هو الاحتياط في المشكوكات والمظنونات بالظن الغير الاطميناني إن أمكن وإلا فبالاصول والعمل بالظن في الوقائع المظنونة بالظن الاطميناني.
فإذا علم المكلف قطع بأنه لم يترك القطع بالموافقة الغير الواجب على المكلف من جهة العسر إلا إلى الموافقه الاطمينانية، فيكون مدار العمل على العلم بالبراءة والظن الاطميناني بها.
وأما مورد التخيير، فالعمل فيه على الظن الموجود في المسألة وإن كان ضعيفا فهو خارج عن الكلام، لان العقل لا يحكم فيه بالاحتياط حتى يكون التنزل منه إلى شئ آخر، بل التخيير أو العمل بالظن الموجود تنزل من العلم التفصيلي إليهما بلا واسطة.
وإن شئت قلت: إن العمل في الفقه في مورد الانسداد على الظن الاطميناني ومطلق الظن والتخيير، كل في مورد خاص.وهذا هو الذي يحكم به العقل المستقل.
وقد سبق لذلك مثال في الخارج: وهو ما إذا علمنا بوجود شياه محرمة في قطيع، وكان أقسام القطيع بحسب إحتمال كونها مصداقا للمحرمات خمسة، قسم منها يظن كونها محرمة بالظن القوي الاطميناني، لا أن المحرم منحصر فيه، وقسم منها يظن ذلك فيها بظن قريب من الشك والتحير، وثالث يشك في كونها محمرمة، وقسم منها في مقابل الظن الاول، وقسم منها موهوما في مقابل الظن الثاني.ثم فرضنا في المشكوكات.
وهذا القسم من الموهومات ما يحتمل أن يكون واجب الارتكاب.
وحينئذ فمقتضى الاحتياط وجوب إجتناب الجميع مما لا يحتمل الوجب.
فإذا إنتفى وجوب الاحتياط لاجل العسر واحتيج إلى إرتكاب موهوم الحرمة كان إرتكاب الموهوم في مقابل الظن الاطميناني أولى من الكل، فيبنى على العمل به، ويتخير في المشكوك الذي يحتمل الوجوب، ويعمل بمطلق الظن في المظنون منه.
لكنك خبير بأن هذا ليس من حجية مطلق الظن ولا الظن الاطميناني في شئ، لان معنى حجيته أن يكون دليلا في الفقه، بحيث يرجع في موارد وجوده إليه لا إلى غيره، وفي موارد عدمه إلى مقتضى الاصل الذي يقتضيه.
والظن هنا ليس كذلك، إذ العمل، إما في موارد وجوده، ففيما طابق منه الاحتياط فالعمل على الاحتياط، لا عليه، إذ لم يدل على ذلك مقدمات الانسداد، وفيما خالف الاحتياط لا يعول عليه إلا بمقدار مخالفة الاحتياط لدفع العسر، وإلا فلو فرض فيه جهة أخرى لم يكن معتبرا من تلك الجهة.
كما لو دار الامر بين شرطية شئ وإباحته وإستحبابه فظن بإستحبابه، فإن لا يدل مقدمات دليل الانسداد إلا على عدم وجوب الاحتياط في ذلك الشئ والاخذ بالظن في عدم وجوبه، لا في إثبات إستحبابه.
وإما في موارد عدمه، وهو الشك، فلا يجوز العمل إلا بالاحتياط الكلي الحاصل من إحتمال كون الواقعة من موارد التكليف المعلومة إجمالا وإن كان لا يقتضيه نفس المسألة.
كما إذا شك في حرمة عصير التمر او وجوب الاستقبال بالمحتضر، بل العمل على هذا الوجه تبعيض في الاحتياط وطرحه في بعض الموارد دفعا للحرج، ثم يعين العقل للطرح البعض الذي يكون وجود التكليف فيها إحتمالا ضعيفا في الغاية.
فإن قلت: إن العمل بالاحتياط في المشكوكات منضمة إلى المظنونات يوجب العسر فضلا عن إنضمام العمل به في الموهومات المقابلة للظن الغير القوي، فيثبت وجوب العمل بمطلق الظن و وجوب الرجوع في المشكوكات إلى مقتضى الاصل.
وهذا مساو في المعنى لحجية الظن المطلق، وإن كان حقيقة تبعيضا في الاحتياط الكلي، لكنه لا يقدح بعد عدم الفرق في العمل.
قلت: لا نسلم لزوم الحرج من مراعاة الاحتياط في المظنونات بالظن الغير القوي في نفي التكليف فضلا عن لزومه من الاحتياط في المشكوكات فقط بعد الموهومات.وذلك، لان حصول الظن الاطميناني في الاخبار وغيرها غير عزيز.
أما في غيرها، فلانه كثيرا ما يحصل الاطمينان من الشهرة والاجماع والاستقراء والاولوية.
وأما الاخبار فلان الظن المبحوث عنه في هذا المقام هو الظن بصدور المتن، هو يحصل غالبا من خبر من يوثق بصدقه ولو في خصوص الرواية وإن لم يكن إماميا او ثقة على الاطلاق، إذ ربما يتسامح في غير الروايات بما لا يتسامح فيها.
وأما إحتمال الارسال، فمخالف لظاهر كلام الراوي، وهو داخل في ظواهر الالفاظ، فلا يعتبر
فيها إفادة الظن فضلا عن الاطميناني منه.
فلو فرض عدم حصول الظن بالصدور لاجل عدم الظن بالاسناد، لم يقدح في إعتبار ذلك الخبر، لان الجهة التي يعتبر فيها إفادة الظن الاطيماني هو جهة صدق الراوي في إخباره عمن يروي عنه.
وأما أن إخباره بلا واسطة فهو ظهور لفظي لا بأس بعدم إفادته للظن.
فيكون صدور المتن غير مظنون أصلا، لان النتيجة تابعة لاخس المقدمتين.
وبالجملة، فدعوى (كثرة الظنون الاطمينانية في الاخبار وغيرها من الامارات بحيث لا يحتاج إلى ما دونها ولا يلزم من الرجوع في الموارد الخالية عنها إلى الاحتياط محذور وإن كان هناك ظنون لا تبلغ مرتبة الاطمينان)، قريبة جدا.
إلا أنه يحتاج إلى مزيد تتبع في الروايات وأحوال الرواة وفتاوى العلماء.
وكيف كان، فلا أرى الظن الاطميناني الحاصل من الاخبار وغيرها من الامارات اقل عددا من الاخبار المصححة بعدلين، بل لعل هذا أكثر.
ثم إن الظن الاطميناني من أمارة أو أمارات إذا تعلقت بحجية أمارة ظنية كانت في حكم الاطمينان وإن لم تفده، بناء على ما تقدم من عدم الفرق بين الظن بالحكم والظن بالطريق، إلا أن يدعي مدع قلتها بالنسبة إلى نفسه، لعدم الاطمينان له غالبا من الامارات القوية وعدم ثبوت حجية أمارة بها أيضا.
وحينئذ فيتعين في حقه التعدي منه إلى مطلق الظن.
وأما العمل في المشكوكات بما يقتضيه الاصل في المورد، فلم يثبت، بل اللازم بقاؤه على الاحتياط نظرا إلى كون المشكوكات من المحتملات التي يعلم إجمالا بتحقق التكليف فيها وجوبا و تحريما.
ولا عسر في الاحتياط فيها نظرا إلى قلة ألمشكوكات، لان أغلب المسائل يحصل فيها الظن باحد الطرفين، كما لا يخفى.
مع أن الفرق بين الاحتياط في جميعها والعمل بالاصول الجارية في خصوص مواردها إنما يظهر في الاصول المخالفة للاحتياط.
ولا ريب أن العسر لا يحدث بالاحتياط فيها، خصوصا مع كون مقتضى الاحتياط في شبهه التحريم الترك، وهو غير موجب للعسر.
وحينئذ فلا يثبت المدعى من حجية الظن وكونه دليلا بحيث يرجع في موارد عدمه إلى الاصل، بل يثبت عدم وجوب الاحتياط في المظنونات.
والحاصل: أن العمل بالظن من باب الاحتياط لا يخرج المشكوكات عن حكم الاحتياط الكلي الثابت بمقتضى العلم الاجمالي في الوقائع.
نعم لو ثبت بحكم العقل أن الظن عند إنسداد باب العلم مرجعه في الاحكام الشرعية نفيا
وإثباتا، كالعلم، إنقلب التكليف إلى الظن، وحكمنا بأن الشارع لا يريد إلا الامتثال الظني.
وحيث لا ظن كما في المشكوكات، فالمرجع إلى الاصول الموجودة في خصوصيات المقام.
فيكون كما لو إنفتح باب العلم أو الظن الخاص، فيصير لزوم العسر حكمة في عدم ملاحظة الشارع العلم الاجمالي في الامتثال بعد تعذر التفصيلي، لا علة حتى يدور الحكم مدارها.
ولكن الانصاف: أن المقدمات المذكورة لا تنتج هذه النتيجة، كما يظهر لمن راجعها وتأملها.
نعم لو ثبت أن الاحتياط في المشكوكات يوجب العسر ثبتت النتيجة المذكورة، لكن عرفت فساد دعواه في الغاية.
كدعوى أن العلم الاجمالي المقتضي للاحتياط الكلي إنما هو في موارد الامارات دون المشكوكات، فلا مقتضي فيها للعدول عما يقتضيه الاصول الخاصة في مواردها، فإن هذه الدعوة يكذبها ثبوت العلم الاجمالي بالتكليف الالزامي قبل إستقصاء الامارات، بل قبل الاطلاع عليها، وقد مر تضعيفه سابقا، فتأمل فيه، فإن إدعاء ذلك ليس كل البعيد.
ثم إن نظير هذا الاشكال الوارد في المشكوكات من حيث الرجوع فيها بعد العمل بالظن إلى الاصول العملية وارد فيها، من حيث الرجوع فيها بعد العمل بالظن إلى الاصول اللفظية الجارية في ظواهر الكتاب والسنة المتواترة والاخبار المتيقن كونها ظنونا خاصة.
توضيحه: أن مقدمات دليل الانسداد تقتضي إثبات عدم جواز العمل بأكثر تلك الظواهر، للعلم الاجمالى بمخالفة ظواهرها في كثير من الموارد، فتصير مجملة لا تصلح للاستدلال.
فإذا فرضنا رجوع الامر إلى ترك الاحتياط في المظنونات أو في المشكوكات أيضا، وجواز العمل بالظن المخالف للاحتياط وبالاصل المخالف للاحتياط، فما الذي أخرج تلك الظواهر عن الاجمال حتى يصح بها الاستدلال في المشكوكات، إذ لم يثبت كون الظن مرجعا، كالعلم، بحيث يكفي في الرجوع إلى الظواهر عدم الظن بالمخالفة.
مثلا إذا أردنا التمسك ب (أوفوا بالعقود)، لاثبات صحة عقد إنعقدت أمارة، كالشهرة أو الاجماع المنقول، على فساده.
قيل: لا يجوز التمسك بعمومه، للعلم الاجمالى بخروج كثير من العقود من هذا العموم لا نعلم تفصيلها.
ثم إذا ثبت وجوب العمل بالظن من جهة عدم إمكان الاحتياط في بعض الموارد وكون الاحتياط في جميع موارد إمكانه مستلزما للحرج، فإذا شك في صحة عقد لم يقم على حكمه أمارة
ظنية، قيل: إن الواجب الرجوع إلى عموم الاية.
ولا يخفى أن إجمالها لا يرتفع بمجرد حكم العقل بعدم وجوب الاحتياط فيما ظن فيه بعدم التكليف.
ودفع هذا - كالاشكال السابق - منحصر في أن يكون نتيجة دليل الانسداد حجية الظن كالعلم، ليرتفع الاجمال في الظواهر، لقيامه في كثير من مواردها من جهة ارتفاع العلم الاجمالي، كما لو علم تفصيلا بعض تلك الموارد، بحيث لا يبقى علم إجمالا في الباقي، أو يدعى أن العلم الاجمالي الحاصل في تلك الظواهر إنما هو بملاحظة موارد الامارات، فلا يقدح في المشكوكات، سواء ثبت حجية الظن أم لا.
وأنت خبير بأن دعوى النتيجة على الوجه المذكور يكذبها مقدمات دليل الانسداد.
ودعوى: (إختصاص المعلوم إجمالا من مخالفة الظواهر بموارد الامارات)، مضعفة بأن هذا العلم حاصل من دون ملاحظة الامارات ومواردها.
وقد تقدم أن المعيار في دخول طائفة من المحتملات في أطراف العلم الاجمالي لنراعي فيها حكمه وعدم دخولها هو تبديل طائفه من محتملات المعلوم لها دخل في العلم الاجمالي بهذه الطائفة المشكوك دخولها.
فإن حصل العلم الاجمالي كانت من أطراف العلم، وإلا فلا.
وقد يدفع الاشكالان بدعوى قيام الاجماع بل الضرورة على أن المرجع في المشكوكات إلى العمل بالاصول اللفظية إن كانت، وإلا فإلى الاصول العملية.
وفيه: أن هذا الاجماع مع ملاحظة الاصول في أنفسها، وأما مع طرو العلم الاجمالي بمخالفتها في كثير من الموارد غاية الكثرة، فالاجماع، على سقوط العمل بالاصول مطلقا، لا على ثبوته.
ثم إن هذا العلم الاجمالي وإن كان حاصلا لكل أحد قبل تمييز الادلة عن غيرها، إلا أن من تعينت له الادلة وقام الدليل القطعي عنده على بعض الظنون عمل بمؤداها وصار المعلوم بالاجمال عنده معلوما بالتفصيل.
كما إذا نصب أمارة طريقا لتعيين المحرمات في القطيع الذي علم بحرمة كثير من شياهها، فإنه يعمل بمقتضى الامارة، ثم يرجع في مورد فقدها إلى أصالة الحل، لان المعلوم إجمالا صار معلوما بالتفصيل.
والحرام الزائد عليه غير معلوم التحقق في أول الامر.
وأما من لم يقم عنده الدليل على أمارة، إلا أنه ثبت له عدم وجوب الاحتياط والعمل بالامارات، لا من حيث أنها أدلة، بل من حيث أنها مخالفة للاحتياط وترك الاحتياط فيها موجب لاندفاع العسر، فلا دافع لذلك العلم الاجمالي لهذا الشخص بالنسبة إلى المشكوكات.
فعلم مما ذكرنا أن مقدمات دليل الانسداد على تقرير الحكومة وإن كانت تامة في الانتاج إلا
أن نتيجتها لا تفي بالمقصود من حجية الظن وجعله كالعلم أو كالظن الخاص.
وأما على تقرير الكشف فالمستنتج منها وإن كان عين المقصود إلا أن الاشكال والنظر بل المنع في إستنتاج تلك النتيجة.
فإن كنت تقدر على إثبات حجية قسم من الخبر لا يلزم من الاقتصار عليه محذور، كان احسن، وإلا فلا تتعد على تقرير الكشف عما ذكرناه من المسلك في آخره، وعلى تقدير الحكومة ما بينا هنا أيضا من الاقتصار في مقابل الاحتياط على الظن الاطميناني بالحكم أو بطريقية أمارة دلت على الحكم وإن لم تفد إطمينانا، بل ولا ظنا، بناء على ما عرفت مسلكنا المتقدم من عدم الفرق بين الظن بالحكم والظن بالطريق.
وأما في ما لا يمكن الاحتياط فالمتبع فيه - بناء على ما تقدم في المقدمات من سقوط الاصول عن الاعتبار، للعلم الاجمالي بمخالفة الواقع فيها - هو مطلق الظن إن وجد وإلا فالتخيير.
وحاصل الامر عدم رفع اليد عن الاحتياط في الدين مهما أمكن إلا مع الاطمينان بخلافه.
وعليك بمراجعة ما قدمنا من الامارات على حجية الاخبار، عساك تظفر فيها بأمارات توجب الاطمينان بوجوب العمل بخبر الثقة عرفا إذا أفاد الظن وإن لم يفد الاطمينان.
بل لعلك تظفر فيها بخبر مصحح بعدلين مطابق لعمل المشهور مفيد للاطمينان، يدل على حجية المصحح بواحد عدل، نظرا إلى حجية قول الثقة المعدل في تعديله، فيصير بمنزلة المعدل بعدلين حتى يكون المصحح بعدل واحد متبعا، بناء على دليل الانسداد بكلا تقريريه، لان المفروض حصول الاطمينان من الخبر القائم على حجية قول الثقة المعدل المستلزم لحجية المصحح بعدل واحد، بناء على شمول دليل إعتبار خبر الثقة للتعديلات، فيقضي به تقرير الحكومة، وكون مثله متيقن الاعتبار من بين الامارات فيقضي به تقرير الكشف.
المقام الثالث: تعميم الظن على تقرير الكشف أو على تقرير الحكومة
في أنه إذا بني على تعميم الظن، فإن كان التعميم على تقرير الكشف، بأن يكون مقدمات الانسداد كاشفة عن حكم الشارع بوجوب العمل بالظن في الجملة ثم تعميمه بإحدى المعممات المتقدمة، فلا إشكال من جهة العلم بخروج القياس عن هذا العموم، لعدم جريان المعمم فيه بعد وجود الدليل على حرمة العمل به، فيكون التعميم بالنسبة إلى ما عداه، كما لا يخفى على من راجع المعممات المتقدمة.
وأما على تقرير الحكومة، بأن يكون مقدمات الدليل موجبة لحكومة العقل بقبح إرادة الشارع ما عدا الظن وقبح إكتفاء المكلف على ما دونه، فيشكل توجيه خروج القياس، وكيف يجامع حكم العقل بكون الظن كالعلم مناطا للاطاعة والمعصية ويقبح عن الآمر والمأمور التعدي عنه.
ومع ذلك يحصل الظن او خصوص الاطمينان من القايس، ولا يجوز الشارع العمل به.
فإن المنع عن العمل بما يقتضيه العقل من الظن أو خصوص الاطمينان لو فرض ممكنا جرى في غير القياس فلا يكون العقل مستقلا، إذ لعله نهى عن امارة، مثل ما نهى عن القياس بل وأزيد، واختفى علينا.
ولا دافع لهذا الاحتمال إلا قبح ذلك على الشارع، إذ إحتمال صدور الممكن بالذات عن الحكيم لا يرتفع إلا بقبحه.
وهذا من أفراد ما إشتهر من أن الدليل العقلي لا يقبح التخصيص، ومنشأة لزوم التناقض.
ولا يندفع إلا بكون الفرد الخارج عن الحكم خارجا عن الموضوع وهو التخصص.
وعدم التناقض في تخصيص العمومات اللفظية إنما هو لكون العموم صوريا، فلا يلزم إلا التناقض الصوري.
ثم إن الاشكال هنا في مقامين:
أحدهما في خروج مثل القياس وأمثاله مما نقطع بعدم إعتباره.
الثاني في حكم الظن الذي قام على عدم إعتباره ظن آخر، حيث أن الظن المانع والممنوع متساويان في الدخول تحت دليل الانسداد ولا يجوز العمل بهما، فهل يطرحان أو يرجح المانع أو الممنوع منه أو يرجع إلى الترجيح؟ وجوه بل أقوال.
أما المقام الاول [ وهو خروج القياس وأمثاله مما نقطع بعدم إعتباره ]
فقد قيل في توجيهه أمور:
الاول: ما مال إليه أو قال به بعض، من منع حرمة العمل بالقياس في أمثال زماننا.
وتوجيهه، بتوضيح منا، أن الدليل على الحرمة إن كان هي الاخبار المتواترة معنى في الحرمة، فلا ريب أن بعض تلك الاخبار في مقابلة معاصري الائمة، صلوات الله عليهم، من العامة التاركين للثقلين، حيث تركوا الثقل الاصغر الذي عنده علم الثقل الاكبر، ورجعوا إلى إجتهاداتهم وآرائهم، فقاسوا واستحسنوا وضلوا وأضلوا.
وإليهم أشار النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، في بيان من يأتى من بعده من الاقوام.
فقال: (برهة يعملون بالقياس).
والامير، صلوات الله عليه، بما معناه: (إن قوما تفلتت عنهم الاحاديث أن يحفظوها وأعوزتهم النصوص أن يعوها فتمسكوا بآرائهم)، إلى آخر الرواية.
وبعض منها إنما يدل على الحرمة من حيث أنه ظن لا يغني من الحق شيئا.
وبعض منها يدل على الحرمة من حيث إستلزامه لابطال الدين ومحق السنة، لاستلزامه الوقوع غالبا في خلاف الواقع.
وبعض منها يدل على الحرمة و وجوب التوقف إذا لم يوجد ما عداه، ولازمه الاختصاص بصورة التمكن من إزالة التوقف، لاجل العمل بالرجوع إلى أئمة الهدى، عليهم السلام، أو بصورة ما إذا كانت المسألة من غير العمليات أو نحو ذلك.
ولا يخفى أن شيئا من الاخبار الواردة على أحد هذه الوجوه المتقدمة، لا يدل على حرمة العمل بالقياس الكاشف عن صدور الحكم عموما أو خصوصا عن النبي، صلى الله عليه وآله، أو أحد أمنائه، صلوات الله عليهم أجمعين، مع عدم التمكن من تحصيل العلم به ولا الطريق الشرعي، ودوران الامر بين العمل بما يظن أنه صدر منهم عليهم السلام، والعمل بما يظن أن خلافه صدر منهم عليهم السلام، كمقتضى الاصول المخالفة للقياس في موارده أو الامارات المعارضة له.وما ذكرنا واضح على من راعى الانصاف وجانب الاعتساف.
وإن كان الدليل هو الاجماع بل الضرورة عند علماء المذهب، كما ادعي، فنقول: إنه كذلك، إلا أن دعوى الاجماع على الحرمة في كل زمان ممنوعة.
ألا ترى أنه لو فرض - والعياذ بالله - إنسداد باب الظن من الطرق السمعية لعامة المكلفين أو لمكلف واحد بإعتبار ما سنح له من البعد عن بلاد الاسلام، فهل تقول: إنه يحرم عليه العمل بما يظن بواسطة القياس أنه الحكم الشرعي المتداول بين المتشرعة وأنه مخير بين العمل به والعمل بما يقابله من الاحتمال الموهوم، ثم تدعي الضرورة على ما ادعيته من الحرمة، حاشاك.
ودعوى: (الفرق بين زماننا هذا وزمان إنطماس جميع الامارات السمعية) ممنوعة، لان المفروض أن الامارات السمعية الموجودة بأيدينا لم يثبت كونها متقدمة في نظر الشارع على القياس، لان تقدمها على القياس إن كان لخصوصية فيها، فالمفروض بعد إنسداد باب الظن الخاص عدم ثبوت خصوصية فيها، واحتمالها بل ظنها لا يجدي، بل نفرض الكلام فيما إذا قطعنا بأن الشارع لم ينصب تلك الامارات بالخصوص وإن كان لخصوصية في القياس أوجبت كونه دونها في المرتبة، فليس الكلام إلا في ذلك.
وكيف كان، فدعوى الاجماع والضرورة في ذلك في الجملة مسلمة، وأما كليته فلا، وهذه الدعوى ليست بأولى من دعوى السيد ضرورة المذهب على حرمة العمل باخبار الآحاد.
لكن الانصاف: أن إطلاق بعض الاخبار وجميع معاقد الاجماعات يوجب الظن المتاخم
للعلم، بل العلم بأنه ليس مما يركن إليه في الدين مع وجود الامارات السمعية.
فهو حينئذ مما قام الدليل على عدم حجيته، بل العمل بالقياس المفيد للظن في مقابل الخبر الصحيح، كما هو لازم القول بدخول القياس في مطلق الظن المحكوم بحجيته، ضروري البطلن في المذهب.
الثاني: منع إفادة القياس للظن، خصوصا بعد ملاحظة أن الشارع جمع في الحكم بين ما يتراءى متخالفة وفرق بين ما يتخيل متوالفة.
وكفاك في هذا عموم ما ورد من: (أن دين الله لا يصاب بالعقول، وأن السنة إذا قيست محق الدين، وأنه لا شئ أبعد عن عقول الرجال من دين الله)، وغيرها، مما دل على غلبة مخالفة الواقع في العمل بالقياس، وخصوص رواية أبان بن تغلب الواردة في دية أصابع الرجل والمرأة الاتية.
وفيه: أن منع حصول الظن من القياس في بعض الاحيان مكابرة مع الوجدان.
وأما كثرة تفريق الشارع بين المؤتلفات وتأليفه بين المختلفات، فلا يؤثر في منع الظن، لان هذه الموارد بالنسبة إلى موارد الجمع بين المؤتلفات أقل قليل.
نعم الانصاف أن ما ذكر من الاخبار في منع العمل بالقياس موهن قوي يوجب غالبا إرتفاع الظن الحاصل منه في بادي النظر.
وأما منعه عن ذلك دائما فلا، كيف؟ وقد يحصل من القياس القطع، وهو المسمى عندهم بتنقيح المناط القطعي.
وأيضا فالاولوية الاعتبارية من أقسام القياس، ومن المعلوم إفادتها للظن، لا ريب أن منشأ الظن فيها هو إستنباط المناط ظنا، وأما آكديته في الفرع فلا مدخل له في حصول الظن.
الثالث: أن باب العلم في مورد القياس ومثله مفتوح، للعلم بأن الشارع أرجعنا في هذه الموارد إلى الاصول اللفظية أو العملية، فلا يقضتي دليل الانسداد إعتبار ظن القياس في موارده.
وفيه: أن هذا العلم إنما حصل من جهة النهي عن القياس.
ولا كلام في وجوب الامتناع عنه بعد منع الشارع، إنما الكلام في توجيه صحة منع الشارع عن العمل به، مع أن موارده وموارد سائر الامارات متساوية.
فإن أمكن منع الشارع عن العمل بالقياس أمكن ذلك في أمارة أخرى، فلا يستقل العقل بوجوب العمل بالظن وقبح الاكتفاء بغيره من المكلف.
وقد تقدم أنه لولا ثبوت القبح في التكليف بالخلاف لم يستقل العقل بتعين العمل بالظن، إذ لا مانع عقلا عن وقوع الفعل الممكن ذاتا من الحكيم إلا قبحه.
والحاصل: ان الانفتاح المدعى إن كان مع قطع النظر عن منع الشارع فهو خلاف المفروض.
وإن كان بملاحظة منع الشارع، فالاشكال.في صحة المنع ومجامعته مع إستقلال العقل بوجوب العمل بالظن.
فالكلام هنا في توجيه المنع، لا في تحققه.
الرابع: أن مقدمات دليل الانسداد، أعنى إنسداد باب العلم مع العلم ببقاء التكليف، إنما توجب جواز العمل بما يفيد الظن في نفسه ومع قطع النظر عما يفيد ظنا أقوى.
وبالجملة هي تدل على حجية الادلة الظنية دون مطلق الظن النفس الامري.
والاول أمر قابل للاستثناء، إذ يصح أن يقال: (إنه يجوز العمل بكل ما يفيد الظن بنفسه ويدل على مراد الشارع ظنا إلا الدليل الفلاني، وبعد إخراج ما خرج عن ذلك يكون باقي الادلة المفيدة للظن حجة معتبرة.
فإذا تعارضت تلك الادلة لزم الاخذ بما هو الاقوى وترك ما هو الاضعف، فالمعتبر حينئذ هو الظن بالواقع ويكون مفاد الاقوى حنيئذ ظنا والاضعف وهما، فيؤخذ بالظن ويترك غيره)، إنتهى.
أقول: كأن غرضه، بعد فرض جعل الاصول من باب الظن وعدم وجوب العمل بالاحتياط، أن انسداد باب العلم في الوقائع مع بقاء التكليف فيها يوجب عقلاالرجوع إلى طائفة من الامارات الظنية.
وهذه القضية يمكن أن تكون مهملة، ويكون القياس خارجا عن حكمها، لا أن العقل يحكم بعمومها ويخرج الشارع القياس، لان هذا عين ما فر منه من الاشكال.
فإذا علم بخروج القياس عن هذا الحكم، فلا بد من إعمال الباقي في مواردها.
فإذا وجد في مورد أصل وأمارة - والمفروض أن الاصل لا يفيد الظن في مقابل الامارة - وجب الاخذ بها.
وإذا فرض خلو المورد عن الامارة أخذ بالاصل، لانه يوجب الظن بمقتضاه.
وبهذا التقرير يجوز منع الشارع عن القياس.
بخلاف ما لو قررنا دليل الانسداد على وجه يقتضي الرجوع في كل مسألة إلى الظن الموجود فيها.
فإن هذه القضية لا تقبل الاهمال ولا التخصيص، إذ ليس في كل مسألة إلا ظن واحد.
وهذا معنى قوله في مقام آخر: (إن القياس مستثنى من الادلة الظنية، لا أن الظن القياسي مستثنى من مطلق الظن).
والمراد بالاستثناء هنا إخراج ما لولاه لكان قابلا للدخول، لا داخلا بالفعل، وإلا لم يصح بالنسبة إلى المهملة.
هذا غاية ما يخطر بالبال في كشف مراده.
وفيه: أن نتيجة المقدمات المذكورة لا تتغير بتقريرها على وجه دون وجه، فإن مرجع ما ذكر من
الحكم بوجوب الرجوع إلى الامارات الظنية في الجملة إلى العمل بالظن في الجملة، إذ ليس لذات الامارة مدخلية في الحجية في لحاظ العقل، والمناط هو وصف الظن، سواء اعتبر مطلقا أو على وجه الاهمال.
وقد تقدم: أن النتيجة على تقدير الحكومة ليست مهملة، بل هي معينة للظن الاطميناني مع الكفاية ومع عدمها فمطلق الظن، وعلى كلا التقديرين لا وجه لاخراج القياس.وأما على تقرير الكشف فهي مهملة لا يشكل معها خروج القياس.
إذ الاشكال مبني على عدم الاهمال وعموم النتيجة، كما عرفت.
الخامس: أن دليل الانسداد إنما يثبت حجية الظن الذي لم يقم على عدم حجيته دليل.فخروج القياس على وجه التخصص دون التخصيص.
توضيح ذلك: أن العقل إنما يحكم بإعتبار الظن عدم الاعتناء بالاحتمال الموهوم في مقام الامتثال، لان البراءة الظنية تقوم مقام العلمية.
أما إذا حصل بواسطة منع الشارع القطع بعدم البراءة بالعمل بالقياس، فلا يبقى براءة ظنية حتى يحكم العقل بوجوبها.
واستوضح ذلك من حكم العقل بحرمة العلم بالظن وطرح الاحتمال الموهوم عند إنفتاح باب العلم في المسألة، كما تقدم نظيره في تقرير اصالة حرمة العمل بالظن.
فإذا فرض قيام الدليل من الشارع على إعتبار ظن ووجوب العمل به، فإن هذا لا يكون تخصيصا في حكم العقل بحرمة العمل بالظن، لان حرمة العمل بالظن مع التمكن إنما هو لقبح الاكتفاء بما دون الامتثال العلمي مع التمكن من العلمي.
فإذا فرض الدليل على إعتبار ظن ووجوب العمل به صار الامتثال في العمل بمؤداه علميا، فلا يشمله حكم العقل بقبح الاكتفاء بما دون الامتثال العلمي، فما نحن فيه على العكس من ذلك.
وفيه: أنك قد عرفت عند التكلم في مذهب إبن قبة أن التعبد بالظن من التمكن من العلم على وجهين:
أحدهما: على وجه الطريقية بحيث لا يلاحظ الشارع في أمره عدا كون الظن إنكشافا ظنيا للواقع بحيث لا يترتب على العمل به عدا مصلحة الواقع على تقدير المطابقة.
والثاني: على وجه يكون في سلوكه مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع الفائتة على تقدير مخالفة الظن الواقع.
وقد عرفت أن الامر بالعمل بالظن مع التمكن من العلم على الوجه الاول قبيح جدا، لانه مخالف لحكم العقل بعدم الاكتفاء في الوصول إلى الواقع بسلوك طريق ظني يحتمل الافضاء إلى
خلاف الواقع.نعم إنما يصح التعبد على الوجه الثاني.
فنقول: إن الامر فيما نحن فيه كذلك، فإنه بعدما حكم العقل بإنحصار الامتثال عند فقد العلم في سلوك الطريق الظني.
فنهي الشارع عن العمل ببعض الظنون إن كان على وجه الطريقية، بأن نهى عند فقد العلم عن سلوك هذا الطريق من حيث أنه ظن يحتمل فيه الخطأ، فهو قبيح، لانه معرض لفوات الواقع فينتقض به الغرض.
كما كان يلزم ذلك من المر بسلوكه على وجه الطريقية عند التمكن من العلم، لان حال الظن عند الانسداد من حيث الطريقية حال العلم مع الانفتاح لا يجوز النهي عنه من هذه الحيثية في الاول، كما لا يجوز الامر به في الثاني.
فالنهي عنه وإن كان مخرجا للعمل به عن ظن البراءة إلى القطع بعدمها إلا أن الكلام في جواز هذا النهي، لما عرفت من أنه قبيح.
وإن كان على وجه يكشف النهي عن وجود مفسدة في العمل بهذا الظن يغلب على مفسدة مخالفة الواقع اللازمة عند طرحه، فهذا وإن كان جائز حسنا، نظير الامر به على هذا الوجه مع الانفتاح، فهذا يرجع إلى ما سنذكره.
السادس: وهو الذي إخترناه سابقا.
وحاصله: أن النهي يكشف عن وجود مفسدة غالبة على المصلحة الواقعية المدركة على تقدير العمل به.
فالنهي عن الظنون الخاصة في مقابل حكم العقل بوجوب العمل بالظن مع الانسداد، نظير الامر بالظنون الخاصة في مقابل حكم العقل بحرمة العمل بالظن مع الانفتاح.
فإن قلت: إذا بني على ذلك، فكل ظن من الظنون يحتمل أن يكون في العمل به مفسدة كذلك قلت: نعم، ولكن إحتمال المفسدة لا يقدح في حكم العقل بوجوب سلوك طريق يظن معه بالبراءة عند الانسداد.
كما أن إحتمال وجود المصلحة المتداركة لمصلحة الواقع في ظن لا يقدح في حكم العقل بحرمة العمل بالظن مع الانفتاح، وقد تقدم، في آخر مقدمات الانسداد، أن العقل مستقل بوجوب العمل بالظن مع إنسداد باب العلم.
ولا إعتبار بإحتمال كون شئ آخر هو المتعبد به غير الظن، إذ لا يحصل من العمل بذلك المحتمل سوى الشك في البراءة أو توهمها، ولا يجوز العدول عن البراءة الظنية إليهما.
وهذا الوجه وإن كان حسنا وقد إخترناه سابقا، إلا أن ظاهر أكثر الاخبار الناهية عن القياس أنه لا مفسدة فيه إلا الوقوع في خلاف الواقع، وإن كان بعضها ساكتا عن ذلك وبعضها ظاهرا في
ثبوت المفسدة الذاتية، إلا أن دلالة الاكثر أظهر.فهي الحاكمة على غيرها، كما يظهر لمن راجع الجميع.
فالنهي راجع إلى سلوكه من باب الطريقية، وقد عرفت الاشكال في النهي على هذا الوجه.
إلا أن يقال: إن النواهي اللفظية عن العمل بالقياس من حيث الطريقية لا بد من حملها في مقابل العقل المستقل على صورة إنفتاح باب العلم بالرجوع إلى الائمة عليهم السلام.
والادلة القطعية منها كالاجماع المنعقد على حرمة العمل به حتى مع الانسداد لا وجه له غير المفسدة الذاتية.
كما أنه إذا قام دليل على حجية الظن مع التمكن من العلم، نحمله على وجود المصلحة المتداركة لمخالفة الواقع، لان حمله على العمل من حيث الطريقية مخالف لحكم العقل بقبح الاكتفاء بغير العلم مع تيسره.
الوجه السابع: هو أن خصوصية القياس من بين سائر الامارات هي غلبة مخالفتها للواقع.
كما يشهد به قوله عليه السلام: (إن السنة إذا قيست محق الدين)، وقوله: (كان ما يفسده أكثر مما يصلحه)، وقوله: (ليس شئ أبعد عن عقول الرجال من دين الله)، وغير ذلك.
وهذا المعنى لما خفي على العقل الحاكم بوجوب سلوك الطرق الظنية عند فقد العلم، فهو إنما يحكم بها لادراك أكثر الواقعيات المجهولة بها.
فإذا كشف الشارع عن حال القياس وتبين عند العقل حال القياس فيحكم حكما إجماليا بعدم جواز الركون إليه.
نعم إذا حصل الظن منه في خصوص مورد، لا يحكم بترجيح غيره عليه في مقام البراءة عن الواقع، لكن يصح للشارع المنع عنه تعبدا بحيث يظهر منه: أني ما أريد الواقعيات التي تضمنها، فإن الظن ليس كالعلم في عدم جواز تكليف الشخص بتركه والاخذ بغيره، وحينئذ فالمحسن لنهي الشارع عن سلوكه على وجه الطريقية كونه في علم الشارع مؤديا في الغالب إلى مخالفة الواقع.
والحاصل: أن قبح النهي عن العمل بالقياس على وجه الطريقية إما أن يكون لغلبة الوقوع في خلاف الواقع مع طرحه فينا في الغرض، وأما أن يكون لاجل قبح ذلك في نظر الظان، حيث أن مقتضي القياس أقرب في نظره إلى الواقع، فالنهي عنه نقض لغرضه في نظر الظان.
أما الوجه الاول، فهو مفقود في المقام، لان المفروض غلبة مخالفته للواقع.
وأما الوجه الثاني، فهو غير قبيح بعد إمكان حمل الظان النهي في ذلك المورد الشخصي على عدم إرادة الواقع منه في هذه المسألة ولو لاجل إطراد الحكم.
ألا ترى أنه يصح أن يقول الشارع للوسواسي القاطع بنجاسة ثوبه: (ما أريد منك الصلاة بطهارة الثوب)، وإن كان ثوبه في الواقع نجسا، حسما لمادة وسواسه.
ونظيره: أن الوالد إذا أقام ولده الصغير في دكانه في مكانه، وعلم منه أنه يبيع أجناسه بحسب ظنونه القاصرة، صح له منعه عن العمل بظنه.
ويكون منعه في الواقع لاجل عدم الخسارة في البيع، ويكون هذا النهي في نظر الصبي بوجود النفع في المعاملة الشخصية إقداما منه ورضى بالخسارة وترك العمل بما يظنه نفعا، لئلا يقع في الخسارة في مقامات أخر، فإن حصول الظن الشخصي بالنفع تفصيلا في بعض الموارد لا ينافي علمه بأن العمل بالظن القياسي منه ومن غيره في هذا المورد وفي غيره يوجب الوقوع غالبا في مخالفة الواقع.
ولذا علمنا ذلك من الاخبار المتواترة معنى مع حصول الظن الشخصي في الموارد منه، إلا أنه كل مورد حصل الظن، نقول بحسب ظننا إنه ليس من موارد التخلف.
فنحمل عموم نهي الشارع الشامل لهذا المورد على رفع الشارع يده عن الواقع وإغماضه عن الواقع في موارد مطابقة القياس، لئلا يقع في مفسدة تخلفه عن الواقع في أكثر الموارد.
هذا جملة ما حضرني من نفسي ومن غيري في دفع الاشكال، وعليك بالتأمل في هذا المجال، والله العالم بحقيقة الحال.
المقام الثاني: فيما إذا قام ظن من أفراد مطلق الظن على حرمة العمل ببعضها بالخصوص
لا على عدم الدليل على إعتباره فيخرج مثل الشرة القائمة على عدم حجية الشهرة، لان مرجعها إلى إنعقاد الشهرة على عدم الدليل على حجية الشهرة وبقائها تحت الاصل.
وفي وجوب العمل بالظن الممنوع أو المانع أو الاقوى منهما أو التساقط وجوه بل أقوال.
ذهب بعض مشايخنا إلى الاول، بناء على ما عرفت سابقا، من بناء غير واحد منهم على أن دليل الانسداد لا يثبت إعتبار الظن في المسائل الاصولية التي منها مسالة حجية الممنوع.
ولازم بعض المعاصرين الثاني، بناء على ما عرفت منه، من أن اللازم بعد الانسداد تحصيل الظن الطريقي، فلا عبرة بالظن بالواقع ما لم يقم على إعتباره ظن.
وقد عرفت ضعف كلا البنائين وأن نتيجة مقدمات الانسداد هو الظن بسقوط التكاليف الواقعية في نظر الشارع الحاصل بموافقة نفس الواقع وبموافقة طريق رضى الشارع به عن الواقع.
نعم بعض من وافقنا، واقعا أو تنزلا، في عدم الفرق في النتيجة بين الظن بالواقع والظن بالطريق، إختار في المقام وجوب طرح الظن الممنوع نظرا إلى أن مفاد دليل الانسداد، كما عرفت في الوجه الخامس من وجوه دفع إشكال خروج القياس، هو إعتبار كل ظن لم يقم على عدم إعتباره دليل معتبر.
والظن الممنوع مما قام على عدم إعتباره دليل معتبر، وهو الظن المانع، فإنه معتبر حيث لم يقم دليل على المنع منه، لان الظن الممنوع لم يدل على حرمة الاخذ بالظن المانع.
غاية الامر أن الاخذ به مناف للاخذ بالمانع، لا أنه يدل على وجوب طرحه، بخلاف الظن المانع، فإنه يدل على وجوب طرح الظن الممنوع.
فخروج الممنوع من باب التخصص لا التخصيص، فلا يقال: إن دخول أحد المتنافيين تحت
العام لا يصلح دليلا لخروج الآخر مع تساويهما في قابلية الدخول من حيث الفردية.
ونظير ما نحن فيه: ما تقرر في الاستصحاب، من أن مثل إستصحاب طهارة الماء المغسول به الثوب النجس دليل حاكم على إستصحاب نجاسة الثوب وإن كان كل من طهارة الماء ونجاسة الثوب، مع قطع النظر عن حكم الشارع بالاستصحاب متيقنة في السابق مشكوكة في اللاحق، وحكم الشارع بإبقاء كل متيقن في السابق مشكوك في اللاحق متساويا بالنسبة إليهما.
إلا أنه لما كان دخول يقين الطهارة في عموم الحكم بعدم النقض والحكم عليه بالبقاء يكون دليلا على زوال نجاسة الثوب المتيقنة سابقا، فيخرج عن المشكوك لاحقا، بخلاف دخول يقين النجاسة والحكم عليها بالبقاء، فإنه لا يصلح للدلالة على طرو النجاسة للماء المغسول به قبل الغسل وإن كان منافيا لبقائه على الطهارة.
وفيه: أولا، أنه لا يتم فيما إذا كان الظن المانع والممنوع من جنس أمارة واحدة.
كأن يقوم الشهرة مثلا على عدم حجية الشهرة، فإن العمل ببعض أفراد الامارة، وهي الشهرة في المسألة الاصولية دون البعض الاخر، وهي الشهرة في المسأله الفرعية، كما ترى.
وثانيا، أن الظن المانع إنما يكون على فرض إعتباره دليلا على عدم إعتبار الممنوع، لان الامتثال بالممنوع حيئنذ مقطوع العدم.كما تقرر في توضيح الوجه الخامس من وجوه دفع إشكال خروج القياس.وهذا المعنى موجود في الظن الممنوع.
مثلا، إذا فرض صيرورة الاولوية مقطوعة الاعتبار بمقتضى دخولها تحت دليل الانسداد لم يعقل بقاء الشهرة المانعة عنها على إفادة الظن بالمنع.
ودعوى: (أن بقاء الظن من الشهرة بعدم إعتبار الاولوية دليل على عدم حصول القطع من دليل الانسداد بحجية الاولوية، وإلا لارتفع بعدم حجيتها.
فكيشف ذلك عن دخول الظن المانع تحت دليل الانسداد)، معارضة بأنا لا نجد من أنفسنا القطع بعدم تحقق الامتثال بسلوك الطريق الممنوع، فلو كان الظن المانع داخلا لحصل القطع بذلك.
وحل ذلك: أن الظن بعدم إعتبار الممنوع إنما هو مع قطع النظر عن ملاحظة دليل الانسداد، ولا نسلم بقاء الظن بعد ملاحظته.
ثم إن الدليل العقلي يفيد القطع بثبوت الحكم بالنسبة إلى جميع أفراد موضوعه.
فإذا تنافي دخول فردين فإما أن يكشف عن فساد ذلك الدليل، وإما أن يجب طرحهما، لعدم حصول القطع من ذلك الدليل العقلي بشئ منهما، وإما أن يحصل القطع بدخول أحدهما فيقطع بخروج الاخر، فلا معنى للترديد بينهما وحكومة أحدهما على الاخر.
فما مثلنا به المقام، من إستصحاب طهارة الماء وإستصحاب نجاسة الثوب، مما لا وجه له، لان مرجع تقديم الاستصحاب الاول إلى تقديم التخصص على التخصيص، ويكون أحدهما دليلا رافعا لليقين السابق، بخلاف الاخر.
فالعمل بالاول تخصص وبالثاني تخصيص.
ومرجعه - كما تقرر في مسألة تعارض الاستصحابين - إلى وجوب العمل بالعام تعبدا إلى أن يحصل الدليل على التخصيص.
إلا أن يقال: إن القطع بحجية المانع عين القطع بعدم حجية الممنوع، لان معنى حجية كل شئ وجوب الاخذ بمؤداه.
لكن القطع بحجية الممنوع التي هي نقيض مؤدى المانع مستلزم للقطع بعدم حجية المانع.
فدخول المانع لا يستلزم خروج الممنوع، وإنما هو عين خروجه، فلا ترجيح ولا تخصيص.
بخلاف دخول الممنوع، فإن يستلزم خروج المانع، فيصير ترجيحا من غير مرجح، فافهم.
والاولى أن يقال: إن الظن بعدم حجية الامارة الممنوعة لا يجوز كما عرفت سابقا في (الوجه السادس) - ان يكون من باب الطريقية، بل لا بد أن يكون من جهة إشتمال الظن الممنوع على مفسدة غالبة على مصلحة إدراك الواقع.
وحينئذ فإذا ظن بعدم إعتبار فقد الظن بإدراك الواقع، لكن مع الظن بترتب مفسدة غالبة، فيدور الامر بين المصلحة المظنونة والمفسدة المظنونة، فلا بد من الرجوع إلى الاقوى.
فإذا ظن بالشهرة نهي الشارع عن العمل بالاولوية، فيلاحظ مرتبة هذا الظن.
فكل أولوية في المسألة كان أقوى مرتبة من ذلك الظن الحاصل من الشهرة أخذ به، وكل أولوية كان أضعف منه وجب طرحه.
وإذا لم يتحقق الترجيح بالقوة حكم بالتساقط، لعدم إستقلال العقل بشئ منهما حنيئذ.
هذا إذا لم يكن العمل بالظن المانع سليما عن محذور ترك العمل بالظن الممنوع.
كما إذا خالف الظن الممنوع الاحتياط اللازم في المسألة، وإلا تعين العمل به لعدم التعارض.
الامر الثالث: لا فرق بين الظن من أمارة على حكم وأمارة متعلقة بألفاظ الدليل
أنه لا فرق في نتيجة مقدمات دليل الانسداد بين الظن الحاصل أولا من الامارة بالحكم الفرعي الكلي كالشهرة أو نقل الاجماع على حكم، وبين الحاصل به من أمارة متعلقة بألفاظ الدليل.
كأن يحصل الظن، من قوله تعالى: (فتيمموا صعيدا)، بجواز التيمم بالحجر مع وجود التراب الخالص، بسبب قول جماعة من أهل اللغة: (إن الصعيد هو مطلق وجه الارض).
ثم إن الظن المتعلق بالالفاظ على قسمين ذكرناهما في بحث حجية الظواهر.
أحدهما: ما يتعلق بتشخيص الظواهر، مثل الظن من الشهرة بثبوت الحقائق الشرعية، وبأن الامر ظاهر في الوجوب لاجل الوضع، وأن الامر عقيب الحظر ظاهر في الاباحة الخاصة أو في مجرد رفع الحظر، وهكذا.
والثاني: ما يتعلق بتشخيص إرادة الظواهر وعدمها، كأن يحصل ظن بإرادة المعنى المجازى أو أحد معاني المشترك لاجل تفسير الراوي مثلا أو من جهة كون مذهبه مخالفا لظاهر الرواية.
وحاصل القسمين الظنون غير الخاصة المتعلقة بتشخيص الظواهر أو المرادات، والظاهر حجيتها عند كل من قال بحجية مطلق الظن لاجل الانسداد.
ولا يحتاج إثبات ذلك إلى إعمال دليل الانسداد في نفس المظنون المتعلقة بالافاظ، بأن يقال: إن العلم فيها قليل.
فلو بني الامر على إجراء الاصل لزم كذا وكذا، بل لو إنفتح باب العلم في جميع الالفاظ إلا في مورد واحد وجب العمل بالظن الحاصل بالحكم الفرعي عن تلك الامارة المتعلقة بمعاني الالفاظ عند إنسداد باب العلم في الاحكام.
وهل يعمل بذلك الظن في سائر الثمرات المترتبة على تعيين معنى اللفظ في غير مقام تعيين الحكم الشرعي الكلي، كالوصايا والاقارير والنذرو؟ فيه إشكال.
والاقوى العدم، لان مرجع
العمل بالظن فيها إلى العمل بالظن في الموضوعات الخارجية المترتبة عليها الاحكام الجزئية الغير المحتاجة إلى بيان الشارع حتى يدخل فيما إنسد فيه باب العلم.
وسيجئ عدم إعتبار الظن فيها.
نعم من جعل الظنون المتعلقة بالالفاظ من الظنون الخاصة مطلقا لزمه الاعتبار في الاحكام والموضوعات، وقد مر تضعيف هذا القول عند الكلام في الظنون الخاصة.
وكذا لا فرق بين الظن الحاصل بالحكم الفرعي الكلي من نفس الامارة أو عن أمارة متعلقة بالالفاظ، وبين الحصل بالحكم الفرعي الكلي من الامارة المتعلقة بالموضوع الخارجي، ككون الراوي عادلا او مؤمنا حال الرواية وكون زرارة هو إبن أعين، لا إبن لطيفة، وكون علي بن الحكم هو الكوفي، بقرينة رواية أحمد بن محمد عنه.
فإن جميع ذلك وإن كان ظنا بالموضوع الخارجي، إلا أنه لما كان منشاء للظن بالحكم الفرعي الكلي الذي إنسد فيه باب العلم عمل به من هذه الجهة، وإن لم نعمل به من سائر الجهات المتعلقة بعدالة ذلك الرجل أو بتشخيصه عند إطلاق إسمه المشترك.
ومن هنا تبين أن الظنون الرجالية معتبرة بقول مطلق عند من قال بمطلق الظن في الاحكام، ولا يحتاج إلى تعيين أن إعتبار أقوال أهل الرجال من جهة دخولها في الشهادة أو في الرواية، ولا يقتصر على أقوال أهل الخبرة، بل يقتصر على تصحيح الغير للسند وإن كان من آحاد العلماء إذا أفاد قوله الظن بصدق الخبر المستلزم للظن بالحكم الفرعي الكلي.
وملخص هذا الامر الثالث أن كل ظن تولد منه الظن بالحكم الفرعي الكلي فهو حجة من هذه الجهة، سواء كان الحكم الفرعي واقعيا أو كان ظاهريا، كالظن بحجية الاستصحاب تعبدا وبحجية الامارة الغير المفيدة للظن الفعلي بالحكم، وسواء تعلق الظن أولا بالمطالب العملية أو غيرها أو بالامور الخارجية من غير إستثناء في سبب هذا الظن.
ووجهه واضح، فإن مقتضى النتيجة هو لزوم الامتثال الظني وترجيح الراجح على المرجوح في العمل.
حتى أنه لو قلنا بخصوصية في بعض الامارات بناء على عدم التعميم في نتيجة دليل الانسداد، لم يكن فرق بين ما تعلق تلك الامارة بنفس الحكم أو بما يتولد منه الظن بالحكم.
ولا إشكال في ذلك أصلا إلا أن يغفل غافل عن مقتضى دليل الانسداد فيدعي الاختصاص بالبعض دون البعض من حيث لا يشعر.
وربما تخيل بعض أن العمل بالظنون المطلقة في الرجال غير مختص بمن يعمل بمطلق الظن في الاحكام، بل المقتصر على الظنون الخاصة في الاحكام أيضا عامل بالظن المطلق في الرجال.
وفيه نظر يظهر للمتتبع لعمل العلماء في الرجال، فإنه يحصل القطع بعدم بنائهم فيها على العمل بكل أمارة.
نعم لو كان الخبر المظنون الصدور مطلقا أو بالظن الاطميناني من الظنون الخاصة لقيام الاخبار أو الاجماع عليه، لزم القائل به العمل بمطلق الظن أو الاطميناني منه في الرجال، كالعامل بالظن المطلق في الاحكام.
ثم إنه قد ظهر بما ذكرنا أن الظن في المسائل الاصولية العملية حجة بالنسبة إلى ما يتولد منه من الظن بالحكم الفرعي الواقعي أو الظاهرى.
* * *
وربما منع منه غير واحد من مشايخنا رضوان الله عليهم.
وما استند إليه أو يصح الاستناد إليه للمنع أمران: أحدهما أصالة الحرمة وعدم شمول دليل الانسداد لان دليل الانسداد، إما أن يجري في خصوص المسائل الاصولية كما يجري في خصوص الفروع، وإما أن يقرر دليل الانسداد بالنسبة إلى جميع الاحكام الشرعية، فيثبت حجية الظن في الجميع ويندرج فيها المسائل الاصولية، وإما أن يجري في خصوص المسائل الفرعية، فيثبت به إعتبار الظن في خصوص الفروع، لكن الظن بالمسألة الاصولية يستلزم الظن بالمسألة الفرعية التي تبتنى عيها.وهذه الوجوه بين ما لا يصح وبين منا لا يجدي.
أما الاول، فهو غير صحيح، لان المسائل الاصولية التي ينسد فيها باب العلم ليست في أنفسها من الكثرة بحيث يستلزم من إجراء الاصول فيها محذور كان يلزم من إجراء الاصول في المسائل الفرعية التي إنسد فيها باب العلم، لان ما كان من المسائل الاصولية يبحث فيها عن كون شئ حجة، كمسألة حجية الشهرة ونقل الاجماع وأخبار الاحاد، أو عن كونه مرجحا، فق إنفتح فيها باب العلم وعلم الحجة منها من غير الحجة والمرجح منها من غيره بإثبات حجية الظن في المسائل الفرعية إذ بإثبات ذلك المطلب حصل الدلالة العقلية على أن ما كان من الامارات داخلة في نتيجة دليل الانسداد فهو حجة.
وقس على ذلك معرفة المرجح، فإنا قد علمنا بدليل الانسداد أن كلا من المتعارضين إذا اعتضد بما يوجب قوته على غيره من جهة من الجهات فهو راجح على صاحبه مقدم عليه في العمل.
وما كان منها يبحث فيها عن الموضوعات الاستنباطية، وهي ألفاظ الكتاب والسنة، من حيث إستنباط الاحكام عنهما، كمسائل الامر والنهي وأخواتهما، من الطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين، إلى غير ذلك، فقد علم حجية الظن فيها من حيث إستلزام الظن بها الظن بالحكم الفرعي الكلي الواقعي.
لما عرفت من أن مقتضى دليل الانسداد في الفروع حجية الظن الحاصل بها من الامارة إبتداء، والظن المتولد من أمارة موجودة في مسألة لفظية.
ويلحق بهما بعض المسائل العقلية، مثل وجوب المقدمة وحرمة الضد وإمتناع إجتماع الامر والنهي، والامر مع العلم بإنتفاء شرطه ونحو ذلك مما يستلزم الظن به الظن بالحكم الفرعي، فإنه يكفي في حجية الظن بها بإجراء دليل الانسداد في خصوص الفروع ولا يحتاج إلى إجرائه في الاصول.
وبالجملة، فبعض المسائل الاصولية صارت معلومة بدليل الانسداد وبعضها صارت حجية الظن فيها معلومة بدليل الانسداد في الفروع.
فالباقي منها الذي يحتاج في إثبات حجية الظن فيها إلى إجراء دليل الانسداد في خصوص الاصول ليس في الكثرة بحيث يلزم من العمل بالاصول وطرح الظن الموجود فيها محذور وإن كانت في أنفسها كثيرة، ثمل المسائل الباحثة عن حجية بعض الامارات، كخبر الواحد ونقل الاجماع لا بشرط الظن الشخصي، وكالمسائل الباحثة عن شروط أخبار الآحاد على مذهب من يراها ظنونا خاصة، والباحثة عن بعض المرجحات التعبدية ونحو ذلك، فإن هذه المسائل لا تصير معلومة بإجراء دليل الانسداد في خصوص الفروع.
لكن هذه المسائل بل وأضعافها ليست في الكثرة بحيث لو رجع مع حصول الظن بأحد طرفي المسألة إلى الاصول وطرح ذلك الظن لزم محذور كان يلزم في الفروع.
وأما الثاني - وهو إجراء دليل الانسداد في مطلق الاحكام الشرعية، فرعية كانت أو أصلية - فهو غير مجد، لان النتيجة وهو العمل بالظن لا يثبت عمومه من حيث موارد الظن إلا بالاجماع المركب أو الترجيح بلا مرجح، بأن يقال: إن العمل بالظن في الطهارات دون الديات، مثلا، ترجيح بلا مرجح ومخالف للاجماع.
وهذان الوجهان مفقودان في التعميم والتسوية بين المسائل الفرعية والمسائل الاصولية.
أما فقد الاجماع فواضح، لان المشهور، كما قيل، على عدم إعتبار الظن في الاصول.
وأما وجود المرجح، فلان الاهتمام بالمطالب الاصولية أكثر، لابتناء الفروع عليها.
وكلما كانت المسألة مهمة كان الاهتمام فيها أكثر، والتحفظ عن الخطأ فيها آكد، ولذا يعبرون في مقام المنع عن ذلك بقولهم: إن إثبات مثل
هذا الاصل بهذا مشكل، أو إنه إثبات أصل بخبر، ونحو ذلك.
وأما الثالث، وهو إختصاص مقدمات الانسداد ونتيجتها بالمسائل الفرعية، إلا أن الظن بالمسألة الفرعية قد يتولد من الظن في المسألة الاصولية.
فالمسألة الاصولية بمنزلة المسائل اللغوية يعتبر الظن فيها من حيث كونه منشاء للظن بالحكم الفرعي.
ففيه: أن الظن بالمسألة الاصولية إن كان منشاء للظن بالحكم الفرعي الواقعي، كالباحثة عن الموضوعات المستنبطة والمسائل العقلية، مثل وجوب المقدمة وإمتناع إجتماع الامر والنهي، فقد إعترفنا بحجية الظن فيها.
وأما ما لا يتعلق بذلك وتكون باحثة عن أحوال الدليل من حيث الاعتبار في نفسه أو عند المعارضة، وهي التي منعنا عن حجية الظن فيها، فليس يتولد عن الظن فيها الظن بالحكم الفرعي الواقعي، وإنما ينشأ منه الظن بالحكم الفرعي الظاهري.
وهو مما لم يقتض إنسداد باب العلم بالاحكام الواقعية العمل بالظن فيه، فإن إنسداد باب العلم في حكم العصير العنبي إنما يقتضي العمل بالظن في ذلك الحكم المنسد، لا في حكم العصير من حيث أخبر عادل بحرمته.
بل أمثال هذه الاحكام الثابتة للموضوعات، لا من حيث هي، بل من حيث قيام الامارة الغير المفيدة للظن الفعلي عليها إن ثبت إنسداد باب العلم فيها على وجه يلزم المحذور من الرجوع فيها إلى الاصول عمل فيها بالظن، وإلا فإنسداد باب العلم في الاحكام الواقعية وعدم إمكان العمل فيها بالاصول لا يقتضي العمل بالظن في هذه الاحكام، لانها لا تغنى عن الواقع المنسد فيه العلم.
هذا غاية توضيح ما قرره إستاذنا الشريف، قدس سره اللطيف، في منع نهوض دليل الانسداد لاثبات حجية الظن في المسائل الاصولية.
الثاني من دليلي المنع:
هو أن الشهرة المحققة والاجماع المنقول على عدم حجية الظن في مسائل أصول الفقه، وهي مسالة أصولية، فلو كان الظن فيها حجة وجب الاخذ بالشهرة ونقل الاجماع في هذه المسالة.
والجواب، أما عن الوجه الاول فبأن دليل الانسداد وارد على أصالة حرمة العمل بالظن.
والمختار في الاستدلال به للمقام هو الوجه الثالث، وهو إجراؤه في الاحكام الفرعية، والظن في المسائل الاصولية مستلزم للظن في المسألة الفرعية.
وما ذكر من كون اللازم منه هو الظن بالحكم الفرعي الظاهري صحيح.
إلا أن ما ذكر - من أن إنسداد باب العلم في الاحكام الواقعية وبقاء التكليف بها وعدم جواز الرجوع فيها إلى الاصول لا يقتضي إلا إعتبار الظن بالحكم الفرعي الواقعي - ممنوع، بل المقدمات المذكورة، كما عرفت غير مرة، إنما تقتضي إعتبار الظن بسقوط تلك الاحكام الواقعية وفراغ الذمة منها.
فإذا فرضنا مثلا أنا ظننا بحكم العصير لا واقعا، بل من حيث قام عليه ما لا يفيد الظن الفعلي بالحكم الواقعي.
فهذا الظن يكفي في الظن بسقوط الحكم الواقعي للعصير.
بل لو فرضنا أنه لم يحصل ظن بحكم واقعي أصلا، وإنما حصل الظن بحجية أمور لا تفيد الظن، فإن العمل بها يظن معه سقوط الاحكام الواقعية عنا، لما تقدم من أنه لا فرق في سقوط الواقع بين الاتيان بالواقع علما أو ظنا وبين الاتيان ببدله كذلك.فالظن بالاتيان بالبدل كالظن بإتيان الواقع، وهذا واضح.
وأما الجواب عن الثاني: أولا، فبمنع الشهرة والاجماع، نظرا إلى أن المسألة من المستحدثات، فدعوى الاجماع فيها مساوقة لدعوى الشهرة.
وثانيا، لو سلمنا الشهرة، لكنه لاجل بناء المشهور على الظنون الخاصة، كأخبار الآحاد والاجماع المنقول.
وحيث أن المتبع فيها الادلة الخاصة، وكانت أدلتها كالاجماع والسيرة على حجية أخبار الآحاد مختصة بالمسائل الفرعية بقيت المسائل الاصولية تحت أصالة حرمة العمل بالظن، ولم يعلم بل ولم يظن من مذهبهم الفرق بين الفروع والاصول، بناء على مقدمات الانسداد وإقتضاء العقل كفاية الخروج الظني عن عهدة التكاليف الواقعية.
وثالثا، سلمنا قيام الشهرة والاجماع المنقول على عدم الحجية على تقدير الانسداد، لكن المسالة أعني كون مقتضى الانسداد هو العمل بالطن مطلقا أو في خصوص الفروع عقلية، والشهرة ونقل الاجماع إنما تفيدان الظن في المسائل التوقيفيه دون العقلية.
ورابعا، إن حصول الظن بعدم الحجية منع تسليم دلالة دليل الانسداد على الحجية لا يجتمعان، فتسليم دليل الانسداد يمنع من حصول الظن.
وخامسا، سلمنا حصول الظن، لكن غاية الامر دخول المسألة فيما تقدم من قيام الظن على عدم حجية ظن، وقد عرفت أن المرجع فيه إلى متابعة الظن الاقوى، فراجع.
الامر الرابع: الثابت بالمقدمات هو الاكتفاء بالظن في الخروج عن عهدة الاحكام
ان الثابت بمقدمات دليل الانسداد هو الاكتفاء بالظن في الخروج عن عهدة الاحكام المنسد فيها باب العلم، بمعنى أن المظنون إذا خالف حكم الله الواقعي لم يعاقب بل يثاب عليه، فالظن بالامتثال إنما يكفي في مقام تعيين الحكم الشرعي الممتثل.
وأما في مقام تطبيق العمل الخارجي على ذلك المعين، فلا دليل على الاكتفاء فيه بالظن.
مثلا، إذا شككنا في وجوب الجمعة أو الظهر جاز لنا تعيين الواجب الواقعي بالظن.
فلو ظننا وجوب الجمعة فلا نعاقب على تقدير وجوب الظهر واقعا، لكن لا يلزم من ذلك حجية الظن في مقام العمل على ذبق ذلك الظن، فإذا ظننا بعد مضي مقدار من الوقت بأنا قد أتينا بالجمعة في هذا اليوم، لكن احتمل نسيانها فلا يكفي الظن بالامتثال من هذه الجهة، بمعنى أنه إذا لم نأت بها في الواقع ونسيانها قام الظن بالاتيان مقام العمل به، بل يجب بحكم الاصل وجوب الاتيان بها.
وكذلك لو ظننا بدخول الوقت وأتينا بالجمعة فلا يقتصر على هذا الظن بمعنى عدم العقاب على تقدير مخالفة الظن للواقع بإتيان الجمعة قبل الزوال.
وبالجملة إذا ظن المكلف بالامتثال وبراءة ذمته وسقوط الواقع، فهذا الظن إن كان مستندا إلى الظن في تعيين الحكم الشرعي كان المكلف فيه معذورا مأجورا على تقدير المخالفة للواقع، وإن كان مستندا إلى الظن بكون الواقع في الخارج منه منطبقا على الحكم الشرعي فليس معذورا، بل يعاقب على ترك الواقع أو ترك الرجوع إلى القواعد الظاهرية التي هى المعول لغير العالم.
ومما ذكرنا تبين: أن الظن بالامور الخارجية عند فقد العلم بإنطباقها على المفاهيم الكلية التي تعلق بها الاحكام الشرعية لا دليل على إعتباره، وأن دليل الانسداد إنما يعذر الجاهل فيما إنسد فيه باب العلم، لفقد الادلة المنصوبة من الشارع أو إجمال ما وجد منها.ولا يعذر الجاهل بالامتثال من
غير هذه الجهة، فإن المعذور فيه هو الظن بأن قبلة العراق ما بين المشرق والمغرب.
أما الظن بوقوع الصلاة إليه فلا يعذر فيه.
فظهر إندفاع توهم أنه إذا بني على الامتثال الظني للاحكام الواقعية فلا يجدي إحراز العلم بإنطباق الخارج على المفهوم، لان الامتثال يرجع بالاخرة إلى الامتثال الظني، حيث أن الظان بكون القبلة ما بين المشرق والمغرب إمتثاله للتكاليف الواقعية ظني، علم بما بين المشرق والمغرب أو ظن.
والحاصل: أن حجية الظن في تعيين الحكم بمعنى معذورية الشخص مع المخالفة لا تستلزم حجيته في الانطباق بمعنى معذوريته لو لم يكن الخارج منطبقا على ذلك الذي عين وإلا لكان الاذن في العمل بالظن في بعض شروط الصلاة أو أجزائها يوجب جوازه في سائرها وهو بديهي البطلان.
فعلم أن قياس الظن بالامور الخارجية على المسائل الاصولية واللغوية وإستلزامه الظن بالامتثال قياس مع الفارق، لان جميع هذه يرجع إلى شئ واحد هو الظن بتعيين الحكم.
ثم من المعلوم عدم جريان دليل الانسداد في نفس الامور الخارجية، لانها غير منوطة بأدلة وأمارات مضبوطة حتى يدعى طرو الانسداد فيها في هذا الزمان، فيجرى دليل الانسداد في أنفسها، لان مرجعها ليس إلى الشرع ولا إلى مرجع آخر منضبط.
نعم قد يوجد في الامور الخارجية ما لا يبعد إجراء نظير دليل الانسداد فيه، كما في موضوع الضرر الذي أنيط به أحكام كثيرة، من جواز التيمم والافطار وغيرهما، فيقال: إن باب العلم بالضرر منسد غالبا، إذ لا يعلم غالبا إلا بعد تحققه.
فإجراء أصالة عدمه في تلك يوجب المحذور، وهو الوقوع في الضرر غالبا، فتعين إناطة الحكم فيه بالظن.
هذا إذا أنيط الحكم بنفس الضرر.وأما إذ أنيط بموضوع الخوف فلا حاجة إلى ذلك.بل يشمل حينئذ الشك أيضا.
ويمكن أن يجري مثل ذلك في مثل العدالة والنسب وشبههما من الموضوعات التي يلزم من إجراء الاصول فيها مع عدم العلم الوقوع في مخالفه الواقع كثيرا، فافهم.
الامر الخامس في إعتبار الظن في أصول الدين
والاقوال المستفادة من تتبع كلمات العلماء في هذه المسألة، من حيث وجوب مطلق المعرفة أو الحاصلة من خصوص النظر وكفاية الظن مطلقا أو في الجملة، ستة.
الاول: إعتبار العلم فيها من النظر والاستدلال، وهو المعروف عن الاكثر وادعى عليه العلامة في الباب الحادي عشر من مختصر المصباح إجماع العلماء كافة.
وربما يحكى دعوى الاجماع من العضدي، لكن الموجود منه في مسألة عدم جواز التقليد في القليات من أصول الدين دعوى إجماع الامة على وجوب معرفة الله.
الثاني: إعتبار العلم ولو من التقليد، وهو المصرح به في كلام بعض والمحكى عن آخرين.
الثالث: كفاية الظن مطلقا.
وهو المحكي عن جماعة، منهم المحقق الطوسي في بعض الرسائل المنسوبة إليه، وحكي نسبته إليه في فصوله ولم أجده فيه، وعن المحقق الاردبيلي وتلميذه صاحب المدارك، وظاهر شيخنا البهائي والعلامة المجلسي والمحدث الكاشاني وغيرهم، قدس الله أسرارهم.
الرابع: كفاية الظن المستفاد من النظر والاستدلال دون التقليد.
حكي عن شيخنا البهائي، رحمه الله، في بعض تعليقاته على شرح المختصر أنه نسبه إلى بعض.
الخامس كفاية الظن المستفاد من أخبار الآحاد.
وهو الظاهر مما حكاه العلامة، قدس سره، في النهاية عن الاخباريين، من أنهم لم يعولوا في أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد، وحكاه الشيخ في عدته في مسألة حجية أخبار الآحاد عن بعض غفلة أصحاب الحديث.
والظاهر أن مراده حملة الاحاديث الجامدون على ظواهرها المعرضون عما عداها من البراهين العقلية المعارضة لتلك الظواهر.
السادس: كفاية الجزم بل الظن من التقليد مع كون النظر واجبا مستقلا، لكنه معفو عنه، كما
يظهر من عدة الشيخ، قدس سره، في مسألة حجية أخبار الآحاد وفي أواخر العدة.
* * *
ثم إن محل الكلام في كلمات هؤلاء الاعلام غير منقح.
فالاولى ذكر الجهات التي يمكن أن نتكلم فيها، وتعقيب كل واحدة منها بما يقتضيه النظر من حكمها، فنقول مستعينا بالله: إن مسائل أصول الدين، وهي التي لا يطلب فيها أولا وبالذات إلا الاعتقاد باطنا والتدين ظاهرا وإن ترتب على وجوب ذلك بعض الاثار العملية على قسمين.
أحدهما ما يجب على المكلف الاعتقاد والتدين به غير مشروط بحصول العلم، كالمعارف، فيكون تحصيل العلم من مقدمات الواجب المطلق فيجب.
الثاني ما يجب الاعتقاد والتدين به إذا إتفق حصول العلم به، كبعض تفاصيل المعارف.
القسم الثاني: الذي يجب الاعتقاد به إذا حصل العلم به
أما الثاني، فحيث كان المفروض عدم وجوب تحصيل المعرفة العلمية، كان الاقوى القول بعدم وجوب العمل فيه بالظن لو فرض حصوله ووجوب التوقف فيه، للاخبار الكثيرة الناهية عن القول بغير علم والآمرة بالتوقف، وأنه: (إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به، وإذا جاءكم ما لا تعلمونه فها.وأهوى بيده إلى فيه).
ولا فرق في ذلك بين أن يكون الامارة الواردة في تلك المسألة خبرا صحيحا أو غيره.
قال شيخنا الشهيد الثانى في المقاصد العلية - بعد ذكر أن المعرفة بتفاصيل البرزخ والمعاد غير لازم -: (وأما ما ورد عنه، صلى الله عليه وآله، في ذلك من طريق الآحاد فلا يجب التصديق به مطلقا وإن كان طريقه صحيحا، لان الخبر الواحد ظني، وقد اختلف في جواز العمل به في الاحكام الشرعية الظنية، فكيف بالاحكام الاعتقادية العلمية)، إنتهى.
وظاهر الشيخ في العدة أن عدم جواز التعويل في أصول الدين على أخبار الآحاد إتفاقي إلا عن بعض غفلة أصحاب الحديث.وظاهر المحكي في السرائر عن السيد المرتضى عدم الخلاف فيه أصلا.
وهو مقتضى كلام كل من قال بعدم إعتبار أخبار الآحاد في أصول الفقه.
لكن يمكن أن يقال إنه إذا حصل الظن من الخبر: فإن أرادوا بعدم وجوب التصديق بمقتضى الخبر عدم تصديقه علما أو ظنا، فعدم حصول الاول كحصول الثاني قهري لا يتصف بالوجوب وعدمه.
وإن أرادوا التدين به الذي ذكرنا وجوبه في الاعتقاديات وعدم الاكتفاء فيها بمجرد الاعتقاد - كما يظهر عن بعض الاخبار الدالة على أن فرض اللسان القول والتعبير عما عقد عليه القلب وأقر به، مستشهدا على ذلك بقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا)، إلخ - فلا مانع من وجوبه في مورد خبر الواحد، بناء على أن هذا نوع عمل بالخبر، فإن ما دل على وجوب تصديق العادل لا يأبى الشمول لمثل ذلك.
نعم لو كان العمل بالخبر لا لاجل الدليل الخاص على وجوب العمل به، بل من جهة الحاجة إليه لثبوت التكليف وإنسداد العلم، لم يكن وجه للعمل به في مورد لم يثبت التكليف فيه بالواقع كما هو المفروض، أو يقال: إن عمدة أدلة حجية الاخبار الآحاد وهي الاجماع العملي لا تساعد على ذلك.
ومما ذكرنا يظهر الكلام في العمل بظاهر الكتاب والخبر المتواتر في أصول الدين، فإنه قد لا يأبى دليل حجية الظواهر عن وجوب التدين بما تدل عليه من المسائل الاصولية التي لم يثبت التكليف بمعرفتها.
لكن ظاهر كلمات كثير عدم العمل بها في ذلك.
ولعل الوجه في ذلك أن وجوب التدين المذكور إنما هو من آثار العلم بالمسألة الاصولية، لا من آثار نفسها.
وإعتبار الظن مطلقا أو الظن الخاص، سواء كان من الظواهر أو غيرها، معناه ترتيب الآثار المتفرعة على نفس الامر المظنون لا على العلم به.
وأما ما يتراءى من التمسك بها أحيانا لعبض العقائد، فلاعتضاد مدلولها بتعدد الظواهر وغيرها من القرائن وإفادة كل منها الظن، فيحصل من المجموع القطع بالمسألة، وليس إستنادهم في تلك المسألة إلى مجرد أصالة الحقيقة التي قد لا تفيد الظن بارادة الظاهر، فضلا عن العلم.
ثم إن الفرق بين القسمين المذكورين وتمييز ما يجب تحصيل العلم به عما لا يجب في غاية الاشكال.
وقد ذكر العلامة في الباب الحادي عشر فيما يجب معرفته على كل مكلف من تفاصيل التوحيد والنبوة والامامة والمعاد أمورا لا دليل على وجوبها كذلك، مدعيا أن الجاهل بها عن نظر وإستدلال خارج عن ربقة الايمان مستحق للعذاب الدائم.
وهو في غاية الاشكال.
نعم يمكن أن يقال: إن مقتضي عموم وجوب المعرفة، مثل قوله تعالى: (وما خلقت الجن
والانس إلا ليعبدون)، أي ليعرفون.
وقوله صلى الله عليه وآله: (وما أعلم بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمس)، بناء على أن الافضلية من الواجب، خصوصا مثل الصلاة، تستلزم الوجوب.
وكذا عمومات وجوب التفقه في الدين الشامل للمعارف بقرينة إستشهاد الامام عليه السلام بها، لوجوب النفر لمعرفة الامام بعد موت الامام السابق عليه السلام، وعمومات طلب العلم هو وجوب معرفة الله جل ذكره ومعرفة النبي " ص " والامام عليه السلام.
ومعرفة ما جاء به النبي " ص " على كل قادر يتمكن من تحصيل العلم، فيجب الفحص حتى يحصل اليأس: فإن حصل العلم بشئ من هذه التفاصيل اعتقد وتدين وإلا توقف ولم يتدين بالظن لو حصل له.
ومن هنا قد يقال: إن الاشتغال بالعلم المتكفل لمعرفة الله ومعرفة أوليائه، صلوات الله عليهم، أهم من الاشتغال بعلم المسائل العلمية، بل هو المتعين، لان العمل يصح عن تقليد، فلا يكون الاشتغال بعلمه إلا كفائيا بخلاف المعرفة، هذا.
ولكن الانصاف ممن جانب الاعتساف يقتضي الاذعان بعدم التمكن من ذلك إلا للاوحدي من الناس، لان المعرفة المذكورة لا تصحل إلا بعد تحصيل قوة إستنباط المطالب من الاخبار وقوة نظرية أخرى لئلا يأخذ بالاخبار المخالفة للبراهين العقلية، ومثل هذا الشخص مجتهد في الفروع قطعا، فيحرم عليه التقليد.
ودعوى جوازه له للضرورة ليس بأولى من دعوى جواز ترك الاشتغال بالمعرفة التي لا تحصل غالبا بالاعمال المبتنية على التقليد.هذا إذا لم يتعين عليه الافتاء والمرافعة لاجل قلة المجتهدين.وأما في مثل زماننا فالامر واضح.
فلا تغتر حينئذ بمن قصر إستعداده أو همته عن تحصيل مقدمات إستنباط المطالب الاعتقادية الاصولية والعلمية عن الادلة العقلية والنقلية، فيتركها مبغضا لها، لان الناس أعداء ماجهلوا، ويشتغل بمعرفة صفات الرب جل ذكره وأوصاف حججه، صلوات الله عليهم، بنظر في الاخبار لا يعرف به من ألفاظها الفاعل من المفعول، فضلا عن معرفة الخاص من العام، وبنظر في المطالب العقلية لا يعرف به البديهيات منها، ويشتغل في خلال ذلك بالتشنيع على حملة الشريعة العملية وإستهزائهم بقصور الفهم وسوء النية، فيسأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزءون.
هذا كله حال وجوب المعرفة مستقلا.
وأما إعتبار ذلك في الاسلام أو الايمان فلا دليل عليه، بل يدل على خلافه الاخبار الكثيرة المفسرة لمعنى الاسلام والايمان.
ففي رواية محمد بن سالم عن أبي جعفر، عليه السلام، المروية في الكافي: (إن الله، عزوجل بعث محمدا، صلى الله عليه وأله وسلم، وهو بمكة عشر سنين، ولم يمت بمكة في تلك العشر سنين أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إلا أدخله الله الجنة بإقراره).
وهو إيمان التصديق، فإن الظاهر أن حقيقة الايمان التي يخرج الانسان بها عن حد الكفر الموجب للخلود في النار لم تتغير بعد إنتشار الشريعة.
نعم ظهر في الشريعة أمور صارت ضرورية الثبوت من النبي، صلى الله عليه وسلم، فيعتبر في الاسلام عدم إنكارها.
لكن هذا لا يوجب التغيير، فإن المقصود أنه لم يعتبر في الايمان ازيد من التوحيد والتصديق بالنبي " ص " وبكونه رسولا صادقا فيما يبلغ.
وليس المراد معرفة تفاصيل ذلك، وإلا لم يكن من آمن بمكة من أهل الجنة أو كان حقيقة الايمان بعد إنتشار الشريعة غيرها في صدر الاسلام.
وفي رواية سليم بن قيس عن أمير المؤمنين، عليه السلام: (إن أدنى ما يكون به العبد مؤمنا أن يعرفه الله تبارك وتعالى إياه، فيقر له بالطاعة، ويعرفه نبيه فيقر له بالطاعة، ويعرفه إمامه وحجته في أرضه وشاهده على خلقه فيقر له بالطاعة.
فقلت له: يا أمير المؤمنين ! وإن جهل جميع الاشياء إلا ما وصفت؟ قال: نعم).وهي صريحة في المدعى.
وفي رواية أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: (جعلت فداك، أخبرني عن الدين الذي إفترضه الله تعالى على العباد ما لا يسعهم جهله ولا يقبل منهم غيره ما هو؟) فقال: أعده علي.
فأعاد عليه.
فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت من إستطاع إليه سبيلا، وصوم شهر رمضان - ثم سكت قليلا، ثم قال -: والولاية والولاية، مرتين ثم قال -: هذا الذي فرض الله عزوجل على العباد، لا يسأل الرب العباد يوم القيامة، فيقول: ألا زدتني على ما إفترضت عليك، ولكن من زاد زاده الله.
إن رسول الله " ص " سن سنة حسنة ينبغي للناس الاخذ بها).
ونحوها رواية عيسى بن السري، (قلت لابي عبدالله عليه السلام: حدثني عما بنيت عليه
دعائم الاسلام التي إذا أخذت بها زكى عملي ولم يضرني جهل ما جهلت بعده؟ فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، صلى الله عليه وآله، والاقرار بما جاء من عند الله، وحق في الاموال الزكاة، والولاية التي أمر الله بها ولاية آل محمد " ص "، فإن رسول الله " ص " قال: (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية).
وقال الله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم)، فكان علي، ثم صار من بعده الحسن، ثم من بعده الحسين، ثم من بعده علي بن الحسين، ثم من بعده محمد بن علي، ثم هكذا يكون الامر.
إن الارض لا تصلح إلا بإمام)، الحديث.
وفي رواية أبي اليسع: (قال: قلت لابي عبدالله، عليه السلام، أخبرني عن دعائم الاسلام التي لا يسع أحدا التقصير عن معرفة شئ منها، التي من قصر عن معرفة شئ منها فسد عليه دينه ولم يقبل منه عمله، ومن عرفها وعمل بها صلح دينه وقبل عمله ولم يضق به مما هو فيه لجهل شئ من الامور جهله؟ فقال: شهادة أن لا إله إلا الله، والايمان بأن محمدا رسول الله، صلى الله عليه وآله، والاقرار بما جاء به من عند الله وحق في الاموال الزكاة، والولاية التي أمر الله عزوجل بها ولاية آل محمد صلى الله عليه وآله).
وفي رواية إسماعيل: قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الدين الذي لا يسع العباد جهله.
فقال: الدين واسع، وإن الخوارج ضيقوا على أنفسهم، بجهلهم.
فقلت: جعلت فداك ! أما أحدثك بديني الذي أنا عليه؟ فقال: بلى قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والاقرار بما جاء به من عند الله، وأتولاكم وأبرأ من عدوكم ومن ركب رقابكم وتأمر عليكم وظلمكم حقكم.
فقال: ما جهلت شيئا.
فقال: هو والله الذي نحن عليه.
فقلت: فهل يسلم أحد لا يعرف هذا الامر؟ قال: لا إلا المستضعفين.
قلت: من هم؟ قال: نساؤكم وأولادكم.
قال: أرأيت أم أيمن ! فإني أشهد أنها من أهل الجنة، وما كانت تعرف ما أنتم عليه).
فإن في قوله (ما جهلت شيئا)، دلالة واضحةعلى عدم إعتبار الزائد في أصل الدين.
والمستفاد من الاخبار المصرحة بعدم إعتبار معرفة أزيد مما ذكر فيها في الدين - وهو الظاهر أيضا من جماعة من علمائنا الاخيار، كالشهيدين في الالفية وشرحها والمحقق الثاني في الجعفرية وشارحها وغيرهم - وهو أنه يكفي في معرفة الرب التصديق بكونه موجودا وواجب الوجود لذاته والتصديق بصفاته الثبوتية الراجعة إلى صفتي العلم والقدرة ونفي الصفات الراجعة إلى الحاجة
والحدوث وأنه لا يصدر منه القبيح فعلا أو تركا.
والمراد بمعرفة هذه الامور ركوزها في إعتقاد المكلف، بحيث إذا سألته عن شئ مما ذكر أجاب بما هو الحق فيه لم يعرف التعبير عنه بالعبارات المتعارفة على ألسنة الخواص.
ويكفي في معرفة النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، معرفة شخصه بالنسب المعروف المختص به، والتصديق بنبوته وصدقه، فلا يعتبر في ذلك الاعتقاد بعصمته، أعني كونه معصوما بالملكة من أول عمر إلى آخره.
قال في المقاصد العلية: (ويمكن إعتبار ذلك، لان الغرض المقصود من الرسالة لا يتم إلا به، فينتفي بالفائدة التي بإعتبارها وجب إرسال الرسل.
وهو ظاهر بعض كتب العقائد المصدرة بأن من جهل ما ذكروه فيها فليس مؤمنا مع ذكرهم ذلك.
والاول غير بعيد عن الصواب)، إنتهى.
أقول: والظاهر أن مراده ببعض كتب العقائد هو الباب الحادي عشر للعلامة، قدس سره، حيث ذكر تلك العبارة، بل ظاهره دعوى إجماع العلماء عليه.
نعم يمكن أن يقال: إن معرفة ما عدا النبوة واجبة بالاستقلال على من هو متمكن منه بحسب الاستعداد وعدم الموانع، لما ذكرنا من عمومات وجوب التفقه وكون المعرفة أفضل من الصلوات الواجبة، وأن الجهل بمراتب سفراء الله، جل ذكره، مع تيسر العلم بها تقصير في حقهم وتفريط في حبهم ونقص يجب بحكم العقل رفعه، بل من أعظم النقائص.
وقد أومى النبي، صلى الله عليه وآله، إلى ذلك حيث قال مشيرا إلى بعض العلوم الخارجة من العلوم الشرعية: (إن ذلك علم يضر جهله.
- ثم قال: - إنما العلوم ثلاثة، آية محكمة وفريضة عادلة وسنة قائمة، وما سواهن فهو فضل،).
وقد أشار إلى ذلك رئيس المحدثين في ديباجة الكافي، حيث قسم الناس إلى أهل الصحة والسلامة وأهل المرض والزمانة، وذكر وضع التكليف عن الفرقة الاخيرة.
ويكفي في معرفة الائمة، صلوات الله عليهم، معرفتهم بنسبهم المعروف والتصديق بأنهم أئمة يهدون بالحق ويجب الانقياد إليهم والاخذ منهم.وفي وجوب الزائد على ما ذكر من عصمتهم الوجهان.
وقد ورد في بعض الاخبار تفسير معرفة حق الامام بمعرفة كونه إماما مفترض الطاعة.
ويكفي في التصديق بما جاء به النبي، صلى الله عليه وآله، التصديق بما علم مجيئه به متواترا من أحوال المبدأ والمعاد، كالتكليف بالعبادات والسؤال في القبر وعذابه والمعاد الجسماني والحساب والصراط والميزان والجنة والنار إجمالا، مع تأمل في إعتبار معرفة ما عدا المعاد الجسماني من تلك الامور في الايمان المقابل للكفر الموجب للخلود في النار، للاخبار المتقدمة المستفيضة والسيرة المستمرة، فإنا نعلم بالوجدان جهل كثير من الناس بها من أول البعثة إلى يومنا هذا.
ويمكن أن يقال: إن المعتبر هو عدم إنكار هذه الامور وغيرها من الضروريات، لا وجوب الاعتقاد بها، على ما يظهر من بعض الاخبار، من أن الشاك إذا لم يكن جاحدا فليس بكافر.
ففي رواية زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام: (لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا)، ونحوها غيرها.
ويؤيدها ما عن كتاب الغيبة للشيخ، قدس سره، بأسناده عن الصادق عليه السلام: (إن جماعة يقال لهم الحقية، وهم الذين يقسمون بحق علي ولا يعرفون حقه وفضله، وهم يدخلون الجنة).
وبالجملة، فالقول بأنه يكفي في الايمان الاعتقاد بوجود الواجب الجامع للكمالات المنزه عن النقائص وبنبوة محمد " ص " وبإمامة الائمة، عليهم السلام، والبراءة من أعدائهم والاعتقاد بالمعاد الجسماني الذي لا ينفك غالبا عن الاعتقادات السابقة غير بعيد، بالنظر إلى الاخبار والسيرة المستمرة.
وأما التدين بسائر الضروريات ففي إشتراطه أو كفاية عدم إنكارها أو عدم إشتراطه أيضا، فلا يضر إنكارها إلا مع العلم بكونها من الدين وجوه، أقواها الاخير، ثم الاوسط.
وما إستقربناه في ما يعتبر في الايمان وجدته بعد ذلك في كلام محكي عن المحقق الورع الاردبيلي في شرح الارشاد.
ثم إن الكلام إلى هنا في تمييز القسم الثاني، وهو ما لا يجب الاعتقاد به إلا بعد حصول العلم به عن القسم الاول، وهو ما يجب الاعتقاد به مطلقا، فيجب تحصيل مقدمته، أعني الاسباب المحصلة للاعتقاد، وقد عرفت أن الاقوى عدم الجواز العمل بغير العلم في القسم الثاني.
القسم الاول: الذي يجب فيه النظر لتحصيل الاعتقاد
وأما القسم الاول الذي يجب فيه النظر لتحصيل الاعتقاد، فالكلام فيه يقع تارة بالنسبة إلى القادر على تحصيل العلم وأخرى بالنسبة إلى العاجز، فهنا مقامان.
[ المقام ] الاول في القادر
والكلام في جواز عمله بالظن يقع في موضعين، الاول في حكمه التكليفي، والثاني في حكمه الوضعي من حيث الايمان وعدمه.
فنقول: أما حكمه التكليفي، فلا ينبغي التأمل في عدم جواز إقتصاره على العمل بالظن.
فمن ظن بنبوة نبينا محمد، صلى الله عليه وآله، أو بإمامة أحد من الائمة، صلوات الله عليهم، فلا يجوز له الاقتصار، فيجب عليه مع التفطن لهذه المسألة زيادة النظر، ويجب على العلماء أمره بزيادة النظر ليحصل له العلم إن لم يخافوا عليه الوقوع في خلاف الحق، لانه حينئذ يدخل في قسم العاجز عن تحصيل العلم بالحق، فإن بقاءه على الظن بالحق أولى من رجوعه إلى الشك أو الظن بالباطل فضلا عن العلم به.
والدليل على ما ذكرنا جميع الآيات والاخبار الدالة على وجوب الايمان والتفقه والعلم والمعرفة والتصديق والاقرار والشهادة والتدين وعدم الرخصة في الجهل والشك ومتابعة الظن، وهي أكثر من أن تحصى.
وأما الموضع الثاني، فالاقوى فيه بل المتعين الحكم بعدم الايمان، للاخبار المفسرة للايمان
بالاقرار والشهادة والتدين والمعرفة وغير ذلك من العبائر الظاهرة في العلم.
وهل هو كافر مع ظنه بالحق؟ فيه وجهان، من إطلاق ما دل على أن الشاك وغير المؤمن كافر، وظاهر ما دل من الكتاب والسنة على حصر المكلف في المؤمن والكافر ومن تقييد كفر الشاك في غير واحد من الاخبار بالجحود فلا يشمل ما نحن فيه، ودلالة الاخبار المستفيضة على ثبوت الواسطة بين الكفر والايمان، وقد أطلق عليه في الاخبار الضلال، لكن أكثر الاخبار الدالة على الواسطة مختصة بالايمان بالمعنى الاخص، فيدل على أن من المسلمين من ليس بمؤمن ولا بكافر، لا على ثبوت الواسطة بين الاسلام والكفر، نعم بعضها قد يظهر منه ذلك.
وحينئذ فالشاك في شئ مما يعتبر في الايمان بالمعنى الاخص ليس بمؤمن ولا كافر، فلا يجري عليه أحكام الايمان.
وأما الشاك في شئ مما يعتبر في الاسلام بالمعنى الاعم، كالنبوة والمعاد، فإن إكتفينا في الاسلام بظاهر الشهادتين وعدم الانكار ظاهرا وإن لم يعتقد باطنا فهو مسلم، وإن إعتبرنا في الاسلام الشهادتين مع إحتمال الاعتقاد على طبقهما حتى يكون الشهادتان أمارة على الاعتقاد الباطني فلا إشكال في عدم إسلام الشاك لو علم منه الشك، فلا يجري عليه أحكام المسلمين، من جواز المناكحة والتوارث وغيرهما.
وهل يحكم بكفره ونجاسته حينئذ فيه إشكال من تقييد كفر الشاك في غير واحد من الاخبار بالجحود.
هذا كله في الظان بالحق.وأما الظان بالباطل، فالظاهر.كفره.
بقي الكلام في أنه إذا لم يكتف بالظن وحصل الجزم من تقليد، فهل يكفي ذلك أو لا بد من النظر والاستدلال؟ ظاهر الاكثر الثاني، بل إدعى عليه العلامة، قدس سره، في الباب الحادي عشر الاجماع، حيث قال: (أجمع العلماء على وجوب معرفة الله وصفاته الثبوتية وما يصح عليه وما يمتنع عنه والنبوة والامامة والمعاد بالدليل لا بالتقليد).
فأن صريحه أن المعرفة بالتقليد غير كافية.ومثلها عبارة الشهيد الاول والمحقق الثاني.
وأصرح منهما عبارة المحقق في المعارج، حيث إستدل على بطلان التقليد بأنهإ جزم في غير محله.
لكن مقتضى إستدلال العضدي على منع التقليد بالاجماع على وجوب معرفة الله وأنها لا تحصل بالتقليد هو أن الكلام في التقليد الغير المفيد للمعرفة.وهو الذي يقتضيه أيضا ما ذكره شيخنا في العدة، كما سيجئ كلامه، وكلام الشهيد في
القواعد من عدم جواز التقليد في العقليات ولا في الاصول الضرورية من السمعيات ولا في غيرها مما لا يتعلق به عمل ويكون المطلوب فيها العلم، كالتفاضل بين الانبياء السابقة.
ويعضده أيضا ظاهر ما عن شيخنا البهائي في حاشية الزبده من أن النزاع في جواز التقليد وعدمه يرجع إلى النزاع في كفاية الظن وعدمها.
ويؤيده أيضا إقتران التقليد في الاصول في كلماتهم بالتقليد في الفروع، حيث يذكرون في أركان الفتوى أن المستفتي فيه هي الفروع دون الاصول.
لكن الظاهر عدم المقابلة التامة بين التقليدين، إذ لا يعتبر في التقليد في الفروع حصول الظن، فيعمل المقلد مع كونه شاكا.وهذا غير معقول في أصول الدين التي يطلب فيها الاعتقاد حتى يجري فيه الخلاف.
وكذا ليس المراد من كفاية التقليد هنا كفايته عن الواقع مخالفا كان في الواقع أو موافقا كما في الفروع، بل المراد كفاية التقليد في الحق وسوقط النظر به عنه، إلا أن يكتفي فيها بمجرد التدين ظاهرا وإن لم يعتقد.
لكنه بعيد.ثم إن ظاهر كلام الحاجبي والعضدي إختصاص الخلاف بالمسائل العقلية.
وهو في محله، بناء على ما إستظهرنا منهم، من عدم حصول الجزم من التقليد، لان الذي لا يفيد الجزم من التقليد إنما هو في العقليات المبتنية على الاستدلالات العقلية.
وأما النقليات، فالاعتماد فيها على قول المقلد، كالاعتماد على قول المخبر الذي قد يفيد الجزم بصدقه بواسطة القرائن وفي الحقيقة يخرج هذا عن القليد.
وكيف كان فالاقوى كفاية الجزم الحاصل من التقليد، لعدم الدليل على إعتبار الزائد على المعرفة والتصديق والاعتقاد، وتقييدها بطريق خاص لا دليل عليه.
مع أن الانصاف: أن النظر والاستدلال بالبراهين العقلية للشخص المتفطن لوجوب النظر في الاصول لا يفيد بنفسه الجزم، لكثرة الشبه الحادثة في النفس والمدونة في الكتب، حتى أنهم ذكروا شبها يصعب الجواب عنها للمحققين الصارفين لاعمارهم في فن الكلام، فكيف حال المشتغل به مقدارا من الزمان لاجل تصحيح عقائدة، ليشتغل بعد ذلك بأمور معاشه ومعاده، خصوصا، والشيطان يغتنم الفرصة لالقاء الشبهات والتشكيك في البديهيات، وقد شاهدنا جماعة قد صرفوا أعمارهم ولم يحصلوا منها شيئا إلا القليل.
* * *
المقام الثاني في غير المتمكن من العلم
والكلام فيه تارة في تحقق موضوعه في الخارج، وأخرى في أنه يجب عليه مع اليأس من العلم تحصيل الظن أم لا، وثالثة في حكمه الوضعي قبل الظن وبعده.
أما الاول، فقد يقال فيه بعدم وجود العاجز، نظرا إلى العمومات الدالة على حصر الناس في المؤمن والكافر، مع ما دل على خلود الكافرين بأجمعهم في النار، بضميمة حكم العقل بقبح عقاب الجاهل القاصر، فيكشف ذلك عن تقصير كل غير مؤمن، وأن من تراه قاصرا عاجزا عن العلم قد تمكن من تحصيل العلم بالحق ولو في زمان ما وإن صار عاجزا قبل ذلك أو بعده، والعقل لا يقبح عقاب مثل هذا الشخص.
ولهذا إدعى غير واحد في مسألة التخطئة والتصويب الاجماع على أن المخطئ في العقائد غير معذور.
لكن الذي يقتضيه الانصاف: شهادة الوجدان بقصور بعض المكلفين.
وقد تقدم عن الكليني ما يشير إلى ذلك، وسيجئ من الشيخ، قدس سره، في العدة من كون العاجز عن التحصيل بمنزلة البهائم.هذا مع ورود الاخبار المستفيضة بثبوت الواسطة بين المؤمن والكافر.
وقضيه مناظرة زرارة وغيره مع الامام، عليه السلام، في ذلك مذكورة في الكافي.
ومورد الاجماع، على أن المخطى ء آثم، هو المجتهد الباذل جهده بزعمه، فلا ينافي كون الغافل والملتفت العاجز عن بذل الجهد معذورا غير آثم.
وأما الثاني، فالظاهر فيه عدم وجوب تحصيل الظن عليه، لان المفروض عجزه عن الايمان والتصديق المأمور به، ولا دليل آخر على عدم جوازإ الوقف، وليس المقام من قبيل الفروع في وجوب العمل بالظن مع تعذر العلم، لان المقصود ولا معنى للتوقف فيه، لا بد عند إنسداد باب العلم من العمل على طبق أصل أو ظن.
والمقصود فيما نحن فيه الاعتقاد.
فإذا عجز عنه، فلا دليل على وجوب تحصيل الظن الذي لا يغني عن الحق شيئا، فيندرج في عموم قولهم عليهم السلام: (إذا جاءكم ما لا تعلمون فها).
نعم لو رجع الجاهل بحكم هذه المسألة إلى العالم ورأى العالم منه التمكن من تحصيل الظن بالحق ولم يخف عليه إفضاء نظره الظني إلى الباطل، فلا يبعد وجوب إلزامه بالتصحيل، لان
إنكشاف الحق، ولو ظنا، أولى من البقاء على الشك فيه.
وأما الثالث، فإن لم يقر في الظاهر بما هو مناط الاسلام فالظاهر كفره، وإن أقر به مع العلم بأنه شاك باطنا فالظاهر عدم إسلامه، بناء على أن الاقرار الظاهري مشروط بإحتمال إعتقاده لما يقر به.
وفي جريان حكم الكفر عليه حينئذ إشكال: من إطلاق بعض الاخبار بكفر الشاك، ومن تقييده في غير واحد من الاخبار بالجحود.
مثل رواية محمد بن مسلم، قال: (سأل أبوبصير أبا عبدالله عليه السلام، قال: ما تقول فيمن شك في الله؟ قال: كافر، يا أبا محمد ! قال: فشك في رسول الله " ص "؟ قال: كافر.ثم إلتفت إلى زرارة، فقال: إنما يكفر إذا جحد).
وفي رواية أخرى: (لو أن الناس إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا).
ثم إن جحود الشاك يحتمل أن يراد به إظهار عدم الثبوت وإنكار التدين به، لاجل عدم الثبوت، ويحتمل أن يراد به الانكار الصوري على سبيل الجزم.
وعلى التقديرين، فظاهرها أن المقر ظاهرا، الشاك باطنا الغير المظهر لشكه، غير كافر.
ويؤيد هذا رواية زرارة الواردة في تفسير قوله تعالى: (وآخرون مرجون لامر الله)، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قوم كانوا مشركين، فقتلوا مثل حمزة وجعفر وأشبهاهما من المؤمنين، ثم إنهم دخلوا الاسلام فوحدوا الله وتركوا الشرك، ولم يعرفوا الايمان بقلوبهم فيكونوا مؤمنين فيجب لهم الجنة، ولم يكونوا على جحودهم فيكفروا فيجب لهم النار، فهم على تلك الحالة، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم).
وقريب منها غيرها.
* * *
ولنختم الكلام بذكر كلام السيد الصدر الشارح للوافية، في أقسام المقلد في أصول الدين، بناء على القول بجواز التقليد وأقسامه، بناء على عدم جوازه.
قال: (إن أقسام المقلد على القول بجواز التقليد ستة، لانه إما أن يكون مقلدا في مسألة حقة أو في باطل.
وعلى التقديرين إما أن يكون جازما بها أو ضانا.وعلى
تقديري التقليد في الباطل إما أن يكون إصراره على التقليد مبتنيا على عناد و تعصب بأن حصل له طريق علم إلى الحق فما سلكه وإما لا.فهذه أقسام ستة.
فالاول: وهو من قلد في مسألة حقة جازما بها.مثلا، قلد في وجود الصانع وصفاته وعدله، فهذا مؤمن.واستدل عليه بما تقدم حاصله.
من أن التصديق معتبر من اي طريق حصل إلى أن قال: - الثاني: من قلد في مسألة حقة ظانا بها من دون جزم، فالظاهر إجراء حكم المسلم عليه في الظاهر، إذ ليس حاله بأدون من حال المنافق، سيما إذا كان طالبا للجزم مشغولا بتحصيله فمات قبل ذلك.
أقول: هذا مبني على أن الاسلام مجرد الاقرار الصوري وإن لم يحتمل مطابقته للاعتقاد.
وفيه: ما عرفت من الاشكال وإن دل عليه غير واحد من الاخبار.
الثالث: من قلد في باطل، مثل إنكار الصانع أو شئ مما يعتبر في الايمان وجزم به من غير ظهور حق ولا عناد.
الرابع: من قلد في باطل وظن به كذلك.
والظاهر في هذين إلحاقهما بمن يقام عليه الحجة في يوم القيامة.
وأما في الدنيا فيحكم عليهما بالكفر إن إعتقدا ما يوجبه، وبالاسلام إن لم يكونا كذلك.
فالاول كمن أنكر النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، مثلا.
والثاني كمن أنكر إماما.
الخامس: من قلد في باطل جازما مع العناد.
السادس: من قلد في باطل ظانا كذلك.وهذان يحكم بكفرهما مع ظهور الحق والاصرار.ثم ذكر أقسام المقلد على القول بعدم جواز التقليد.
قال: إنه إما أن يكون مقلدا في حق أو في باطل.وعلى التقديرين مع الجزم أو الظن.وعلى تقديري التقليد في الباطل بلا عناد أو به.وعلى التقادير كلها دل عقله على الوجوب أو بين له غيره، وعلى الدلالة أصر على التقليد أو رجع ولم يحصل له كمال الاستدلال بعد أولا.
فهذه أقسام أربعة عشر.
الاول التقليد في الحق جازما مع العلم بوجوب النظر والاصرار، فهذا مؤمن
فاسق، لاصراره على ترك الواجب.
الثاني: هذه الصورة مع ترك الاصرار والرجوع، فهذا مؤمن غير فاسق الثالث: المقلد في الحق الظان مع الاصرار، والظاهر أنه مؤمن مرجى في الاخرة وفاسق، للاصرار.
الرابع: هذه الصورة مع عدم الاصرار، فهذا مسلم ظاهرا غير فاسق.
الخامس والسادس: المقلد في الحق جازما أو ظانا مع عدم العلم بوجوب الرجوع، فهذان كالسابق بلا فسق.
أقول: الحكم بإيمان هؤلاء لا يجامع مع فرض القول بعدم جواز التقليد، إلا أن يريد بهذا القول قول الشيخ، قدس سره، من وجوب النظر مستقلا، لكن ظاهره ارادة قول المشهور، فالاولى الحكم بعد إيمانهم على المشهور، كما يقتضيه إطلاق معقد إجماع العلامة في أول باب الحادي عشر، لان الايمان عندهم المعرفة الحاصلة عن الدليل لا التقليد.
ثم قال: السابع: المقلد في الباطل جازما معاندا مع العلم بوجوب النظر والاصرار عليه.
فهذا اشد الكافرين.
الثامن: هذه الصورة من غير عناد ولا إصرار، فهذا أيضا كافر.
ثم ذكرك الباقي وقال: إن حكمها يظهر مما سبق).
أقول: مقتضى هذا القول الحكم بكفرهم، لانهم، أولى به من السابقين.
* * *
بقي الكلام فيما نسب إلى الشيخ في العدة من القول بوجوب النظر مستقلا مع العفو، فلا بد من نقل عبارة العدة، فنقول: قال في باب التقليد، بعدما ذكر إستمرار السيره على التقليد في الفروع والكلام في عدم جواز التقليد في الاصول، مستدلا بأنه لا خلاف في أنه يجب على العامي معرفة الصلاة وأعدادها: (وإذا كان لا يتم ذلك إلا بعد معرفة الله ومعرفة عدله ومعرفة النبوه وجب أن لا يصح التقليد في ذلك).
ثم اعترض: بأن السيرة كما جرت له على تقدير المقلدين في الفروع كذلك
جرت على تقدير المقلدين في الاصول عدم الانكار عليهم.
فأجاب: بأن على بطلان التقليد في الاصول أدلة عقلية وشرعية من كتاب وسنة وغير ذلك، وهذا كاف في النكير.
ثم قال: إن المقلد للحق في أصول الديانات وإن كان مخطئنا في تقليده غير مؤاخذ به وأنه معفو عنه.
وإنما قلنا ذلك لمثل هذه الطريقة التي قدمناها، لاني لم أجد أحدا من الطائفة ولا من الائمة، عليهم السلام، قطع مولاة من يسمع قولهم واعتقد مثل إعتقادهم إن لم يستند ذلك إلى حجة من عقل أو شرع.
ثم اعترض: على ذلك بان ذلك لا يجوز، لانه يؤدي إلى الاغراء بما لا يأمن أن يكون جهلا.
وأجاب: يمنع ذلك، لان هذا المقلد لا يمكنه أن يعلم سقوط العقاب عنه فيستديم الاعتقاد، لانه إنما يمكنه معرفة ذلك إذا عرف الاصول وقد فرضنا أنه مقلد في ذلك كله، فكيف يكون إسقاط العقاب مغريا، وإنما يعلم ذلك غيره من العلماء الذين حصل لهم العلم بالاصول وسبروا أحوالهم أن العلماء لم يقطعوا موالاتهم ولا أنكروا عليهم، ولا يسوغ ذلك لهم إلا بعد العلم بسقوط العقاب عنهم.وذلك يخرجه من باب الاغراء.وهذا القدر كاف في هذا الباب إن شاء الله.
وأقوى مما ذكرنا أنه لا يجوز التقليد في الاصول إذا كان للمقلد طريق إلى العلم به، إما على جملة أو تفصيل.
ومن ليس له قدرة على ذلك أصلا فليس بمكلف، وهو بمنزلة البهائم التي ليست مكلفة بحال)، إنتهى.
وذكر، عند الاحتجاج على حجية أخبار الآحاد، ما هو قريب من ذلك.
قال: (وأما ما يرويه قوم من المقلدة، فالصحيح الذي أعتقده أن المقلد للحق وإن كان مخطئا معفو عنه ولا أحكم فيه بحكم الفساق، فلا يلزم على هذا ترك ما نقلوه)، إنتهى.
أقول: ظاهر كلامه، قدس سره، في الاستدلال على منع التقليد بتوقف معرفة الصلاة وأعدادها على معرفة أصول الدين، أن الكلام في القلد الغير الجازم، وحينئذ فلا دليل على العفو.
وما ذكره من عدم قطع العلماء والائمة موالاتهم مع المقلدين، بعد تسليمه والغض عن إمكان كون ذلك من باب الحمل على الجزم بعقائدهم لعدم العلم بأحوالهم، لا يدل على العفو وإنما يدل على كفاية التقليد.
وإمساك النكير عليهم في ترك النظر والاستدلال إذا لم يدل على وجوبه عليهم، لما اعترف به قبل ذلك من كفاية النكير المستفاد من الادلة الواضحة على بطلان التقليد في الاصول، لم يدل على العفو من هذا الواجب المستفاد من الادلة، فلا دليل على العفو من هذا الواجب المعلوم وجوبه.
والتحقيق أن إمساك النكير لو ثبت ولم يحتمل كونه لحمل أمرهم على الصحة ولعملهم بالاصول دليل على عدم الوجوب، لان وجود الادلة لا يكفي في إمساك النكير من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كفى فيه من حيث الارشاد والدلاله على الحكم الشرعي، لكن الكلام في ثبوت التقرير وعدم إحتمال كونه لاحتمال العلم في حق المقلدين.
فالانصاف: أن المقلد الغير الجازم المتفطن لوجوب النظر عليه فاسق مؤاخذ على تركه للمعرفة الجزمية بعقائده، بل قد عرفت إحتمال كفره، لعموم أدلة كفر الشاك.
وأما الغير المتفطن لوجوب النظر لغفلته أو القاصر عن تحصيل الجزم فهو معذور في الاخرة.وفي جريان حكم الكفر إحتمال تقدم.
وأما الجازم فلا يجب عليه النظر والاستدلال وإن علم من عمومات الآيات والاخبار وجوب النظر والاستدلال، لان وجوب ذلك توصلي لاجل حصول المعرفة.
فإذا حصلت سقط وجوب تحصيلها بالنظر، اللهم إلا أن يفهم هذا الشخص منها كون النظر والاستدلال واجبا تعبديا مستقلا أو شرطا شرعيا للايمان، لكن الظاهر خلاف ذلك، فإن الظاهر كون لك من المقدمات العقلية.
الامر السادس: إذا بنينا على عدم حجية ظن فهل يترتب عليه آثار أخر غيرها
إذا بنينا على عدم حجية ظن أو عدم حجية الظن المطلق، فهل يترتب عليه آثار أخر غير الحجية بالاستقلال، مثل كونه جابرا لضعف سند أو قصور دلالة، أو كونه موهنا لحجة أخرى، أو كونه مرجحا لاحد المتعارضين على الآخر.
ومجمل القول في ذلك أنه كما يكون الاصل في الظن عدم الحجية، كذلك الاصل فيه عدم ترتب الاثار المذكورة من الجبر والوهن والترجيح.وأما تفصيل الكلام في ذلك فيقع في مقامات ثلاثة:
المقام الاول: الجبر بالظن الغير المعتبر
فنقول: عدم إعتباره إما أن يكون من جهة ورود النهي عنه بالخصوص كالقياس ونحوه، وإما من جهة دخوله تحت عمومات أصالة حرمة العمل بالظن.
وأما الاول، فلا ينبغي التأمل في عدم كونه مفيدا للجبر، لعموم ما دل على عدم جواز الاعتناء به وإستعماله في الدين.
وأما الثاني، فالاصل فيه وإن كان ذلك إلا أن الظاهر أنه إذا كان المجبور محتاجا إليه من جهة إفادته للظن بالمضمون كالخبر إذا قلنا بكونه حجة بالخصوص لوصف كونه مظنون الصدور، فأفاد تلك الامارة الغير المعتبرة الظن بصدور ذلك الخبر إنجبر قصور سنده به.
إلا أن يدعى أن الظاهر إشتراط حجية ذلك الخبر بإفادته للظن بالصدور، لا مجرد كونه مظنون الصدور ولو حصل الظن
بصدوره من غير سنده.وبالجملة فالمتبع هو ما يفهم من دليل حجية المجبور.
ومن هنا لا ينبغي التأمل في عدم إنجبار قصور الدلالة بالظن المطلق، لان المعتبر في باب الدلالات هو ظهور الالفاظ نوعا في مدلولاتها، لا مجرد الظن بمطابقة مدلولها للواقع ولو من الخارج.
فالكلام إن كان ظاهرا في معنى بنفسه أو بالقرائن الداخلة فهو، وإلا - بأن كان مجملا أو كان دلالته في الاصل ضعيفة، كدلالة الكلام بمفهومه الوصفي - فلا يجدي الظن بمراد الشارع من أمارة خارجية غير معتبرة بالفرض، إذ التعويل حينئذ على ذلك الظن من غير.مدخلية للكلام، بل ربما لا تكون تلك الامارة موجبة للظن بمراد الشارع من هذا الكلام.
غايته إفادته للظن بالحكم الفرعي، ولا ملازمة بينه وبين الظن بإرادته من اللفظ، فقد لا يريده بذلك اللفظ.
نعم قد يعلم من الخارج كون المراد هو الحكم الواقعي.فالظن به يستلزم الظن بالمراد، لكن هذا من باب الاتفاق.
ومما ذكرنا ظهر أن ما إشتهر - من أن ضعف الدلالة منجبر بعمل الاصحاب - غير معلوم المستند، بل وكذلك دعوى إنجبار قصور الدلالة بفهم الاصحاب لم يعلم لها بينة.
والفرق أن فهم الاصحاب وتمسكهم به كاشف ظني عن قرينة على المراد، بخلاف عمل الاصحاب، فإن غايته الكشف عن الحكم الواقعي الذي قد عرفت أنه لا يستلزم كونه مرادا من ذلك اللفظ، كما عرفت.
بقي الكلام في مستند المشهور في كون الشهرة في الفتوى جابرة لضعف سند الخبر.
فإنه إن كان من جهة إفادتها الظن بصدق الخبر، ففيه - مع أنه قد لا يوجب الظن بصدور ذلك الخبر، نعم يوجب الظن بصدور حكم عن الشارع مطابق لمضمون الخبر -: أن جلهم لا يقولون بحجية الخبر المظنون الصدور مطلقا، فإن المحكي عن المشهور إعتبار الايمان في الراوي، مع أنه لا يرتاب في إفادة الموثق للظن.
فإن قيل: إن ذلك لخروج خبر غير الامامي بالدليل الخاص، مثل منطوق آية النبأ، ومثل قوله عليه السلام: (لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا).
قلنا: إن كان ما خرج بحكم الاية والرواية مختصا بما لا يفيد الظن فلا يشمل الموثق، وإن كان عاما لما ظن بصدوره كان خبر غير الامامي المنجبر بالشهرة والموثق متساويين في الدخول تحت الدليل المخرج.
ومثل الموثق خبر الفاسق المتحرز عن الكذب والخبر المعتضد بالاولوية والاستقراء
وسائر الامارات الظنية، مع أن المشهور لا يقولون بذلك، وإن كان لقيام دليل خاص عليه، ففيه المنع من وجود هذا الدليل.
وبالجملة، فالفرق بين الضعيف المنجبر بالشهرة والمنجبر بغيرها من الامارات وبين الخبر الموثق المفيد لمثل الظن الحاصل من الضعيف المنجبر في غاية الاشكال، خصوصا مع عدم العلم بإستناد المشهور إلى تلك الرواية.
وإليه أشار شيخنا في موضع من المسالك بأن جبر الضعيف بالشهرة ضعيف مجبور بالشهرة.
وربما يدعى كون الخبر الضعيف المنجبر من الظنون الخاصة حيث أدعي الاجماع على حجيته ولم يثبت.
وأشكل من ذلك دعوى دلالة منطوق آية النبأ عليه، بناء على أن التبين يعم الظن الحاصل من ذهاب المشهور إلى مضمون الخبر.
وهو بعيد، إذ لو أريد مطلق الظن فلا يخفى بعده، لان المنهي عنه ليس إلا خبر الفاسق المفيد للظن، إذ لا يعمل أحد بالخبر المشكوك صدقه.
وإن أريد البالغ حد الاطمينان فله وجه، غير أنه يقتضي دخول سائر الظنون الجابرة إذا بلغت ولو بضميمة المجبور حد الاطمينان ولا يختص بالشهرة.فالاية تدل على حجية الخبر المفيد للوثوق والاطمينان، ولا بعد فيه.
وقد مر في أدلة الاخبار ما يؤيده أو يدل عليه من حكايات الاجماع والاخبار.
وأبعد من الكل دعوى إستفادة حجيته مما دل من الاخبار، كمقبولة إبن حنظلة والمرفوعة إلى زرارة، على الامر بالاخذ بما إشتهر بين الاصحاب من المتعارضين.
فإن ترجيحه على غيره في مقام التعارض يوجب حجيته في مقام عدم المعارض بالاجماع والاولوية.
وتوضيح فساد ذلك أن الظاهر من الروايتين شهرة الخبر من حيث الرواية.
كما يدل عليه قول السائل فيما بعد ذلك: (فإنهما معا مشهوران)، مع أن ذكر الشهرة من المرجحات يدل على كون الخبرين في أنفسهما معتبرين مع قطع النظر عن الشهرة.
المقام الثاني: في كون الظن الغير المعتبر موهنا
والكلام هنا أيضا يقع تارة فيما علم بعدم إعتباره، وأخرى فيما لم يثبت إعتباره.
وتفصيل الكلام في الاول أن المقابل له إن كان من الامور المعتبرة، لاجل إفادة الظن النوعي، أي لكون نوعه لو خلي وطبعه مفيدا للظن، وإن لم يكن مفيدا له في المقام الخاص، فلا إشكال في عدم وهنه بمقابلة ما علم عدم إعتباره، كالقياس في مقابل الخبر الصحيح بناء على كونه من الظنون الخاصة على هذا الوجه ومن هذا القبيل: القياس في مقابلة الظواهر اللفظية فإنه لا عبرة به أصلا، بناء على كون إعتبارها من باب الظن النوعي.
ولو كان من باب التعبد فالامر أوضح.
نعم لو كان حجيته، سواء كان من باب الظن النوعي او كان من باب التعبد.
مقيدة بصورة عدم الظن على خلافه، كان للتوقف مجال.
ولعله الوجه، فيما حكاه لي بعض المعاصرين عن شيخه: أنه ذكر له مشافهة: (انه يتوقف في الظواهر المعارضة بمطلق الظن على الخلاف حتى القياس وأشباهه).
لكن هذا القول، أعني تقييد حجية الظواهر بصورة عدم الظن على خلافها، بعيد في الغاية.
وبالجملة فيكفي في المطلب ما دل على عدم جواز الاعتناء بالقياس مضافا إلى إستمرار سيرة الاصحاب على ذلك.
مع أنه يمكن أن يقال: إن مقتضى النهي عن القياس - معللا بما حاصله غلبة مخالفته للواقع - يقتضي أن لا يترتب شرعا على القياس أثر، لا من حيث تأثيره في الكشف ولا من حيث قدحه فيما هو كاشف بالذات، فحكمه حكم عدمه، فكان مضمونه مشكوك لا مظنون، بل مقتضى ظاهر التعليل أنه كالموهوم.
فكما أنه لا ينجبر به ضعيف لا يضعف به قوي.
ويويد ما ذكرنا الرواية المتقدمة عن أبان الدالة على ردع الامام له في رد الخبر الوارد في تنصيف دية أصابع المرأة بمجرد مخالفته للقياس، فراجع.وهذا حسن.
لكن الاحسن منه تخصيص ذلك بما كان إعتباره من قبل الشارع.كما لو دل الشرع على حجية الخبر ما لم يكن ظن على خلافه.فإن نفي الاثر شرعا من الظن القياسي يوجب بقاء إعتبار تلك الامارة على حاله.
وأما ما كان إعتباره من باب بناء العرف وكان مرجع حجيته شرعا إلى تقرير ذلك البناء، كظواهر الالفاظ، فإن وجود القياس إن كان يمنع عن بنائهم فلا يرتفع ذلك بما ورد من قصور القياس عن الدلالة على الواقع.
فتأثير الظن بالخلاف في القدح في حجية الظواهر ليس مثل تاثيره في القدح في حجية الخبر المظنون الخلاف في كونه مجعولا شرعيا يرتفع بحكم الشارع بنفي الاثر عن القياس، لان المنفي في حكم الشارع من آثار الشئ الموجود حسا هي الاثار المجعولة دون غيرها.
نعم يمكن أن يقال: إن العرف بعد تبين حال القياس لهم من قبل الشارع لا يعبأون به في مقام إستنباط أحكام الشارع من خطاباته، فيكون النهي عن القياس ردعا لبنائهم على تعطيل الظواهر لاجل مخالفتها للقياس.
ومما ذكرنا يعلم حال القياس في مقابل الدليل الثابت حجيته بشرط الظن.
كما لو جعلنا الحجة من الاخبار المظنون الصدور منها أو الموثوق به منها، فإن في وهنهما بالقياس الوجهين: من حيث رفعه للقيد المأخوذ في حجيتها على وجه الشرطية، فمرجعه إلى فقدان شرط وجداني، أعني وصف الظن بسبب القياس.
ونفي الآثار الشرعية للظن القياسي لا يجدي، لان الاثر المذكور، أعني رفع الظن، ليس من الامور المجعولة، ومن أن أصل إشتراط الظن من الشارع.
فإذا علمنا من الشارع أن الخبر المزاحم بالظن القياسي لا ينقص أصلا من حيث الايصال إلى الواقع وعدمه من الخبر السليم عن مزاحمته، وأن وجود القياس وعدمه في نظره سيان.
فلا إشكال في الحكم بكون الخبرين المذكورين عنده على حد سواء.
ومن هنا يمكن جريان التفصيل السابق: بأنه إن كان الدليل المذكور المقيد إعتباره بالظن مما دل الشرع على إعتباره، لم يزاحمه القياس الذي دل الشرع على كونه كالعدم من جميع الجهات التي لها مدخل في الوصول إلى دين الله، وإن كان مما دل على إعتباره العقل الحاكم بتعيين الاخذ بالراجح عند إنسداد باب العلم والطرق الشرعية، فلا وجه لاعتباره مع مزاحمة القياس الرافع لما هو مناط حجيته أعني الظن.
فإن غاية الامر صيرورة مورد إجتماع تلك الامارة والقياس مشكوكا، فلا يحكم العقل فيه بشئ، إلا أن يدعي المدعى أن العقل بعد تبين حال القياس لا يسقط عنده الامارة المزاحمة به عن القوة التي تكون لها على تقدير عدم المزاحم وإن كان لا يعبر عن تلك القوة حينئذ بالظن وعن مقابلها بالوهم.
والحاصل: أن العقلاء، إذا وجدوا في شهرة خاصة أو إجماع منقول مقدارا من القوة والقرب إلى الواقع، والتجأوا إلى العمل على طبقهما مع فقد العلم، وعلموا حال القياس ببيان الشارع أنه لا عبرة بما يفيده من الظن ولا يرضى الشارع بدخله في دين الله، لم يفرقوا بين كون الشهرة والاجماع المذكورين مزاحمين بالقياس أم لا، لانه لا ينقصهما عما هما عليه من القوة والمزية المسماة بالظن الشأني والنوعي والطبعي.
ومما ذكرنا صح للقائلين بمطلق الظن لاجل الانسداد، إلا ما خرج، أن يقولوا بحجية الظن الشأني، بمعنى أن الظن الشخصي إذا إرتفع عن الامارات المشمولة لدليل الانسداد بسبب الامارات الخارجة عنه لم يقدح ذلك في حجيتها، بل يجب القول بذلك على رأي بعضهم ممن يجري دليل الانسداد في كل مسألة مسألة، لانه إذا فرض في مسألة وجود أمارة مزاحمة بالقياس، فلا وجه للاخذ بخلاف تلك الامارة، فافهم.
هذا كله مع إستمرار السيرة على عدم ملاحظة القياس في مورد من الموار الفقهية وعدم الاعتناء به في الكتب الاصولية.
فلو كان له أثر شرعي ولو في الوهن، لوجب التعرض لاحكامه في الاصول، والبحث والتفتيش عن وجوده في كل مورد من موارد الفروع، لان الفحص عن الموهن كالفحص عن المعارض واجب، وقد تركه أصحابنا في الاصول والفروع، بل تركوا روايات من اعتنى به منهم وإن كان من المؤسسين لتقرير الاصول وتحرير الفروع، كالاسكافي، الذي نسب إليه أن تدوين (أصول الفقه) من الامامية منه ومن العماني يعني إبن عقيل، قدس سرهما، وفي كلام آخر: إن تحرير الفتاوى في الكتب المستقلة منهما أيضا، جزاهما الله وجميع من سبقهما ولحقهما خير الجزاء.
ثم إنك تقدر بملاحظة ما ذكرنا في التفصي عن إشكال خروج القياس عن عموم دليل الانسداد من الوجوه على التكلم فيما سطرنا ههنا نقضا وإبراما.
هذا تمام الكلام في وهن الامارة المعتبرة بالظن المنهي عنه بالخصوص، كالقياس وشبهه.
وأما الظن الذي لم يثبت إلغاؤه إلا من جهة بقائه تحت أصالة حرمة العمل بالظن، فلا إشكال في وهنه لما كان من الامارات إعتبارها مشروطا بعدم الظن بالخلاف، فضلا عما كان إعتباره مشروطا بإفادة الظن، والسر فيه إنتفاء الشرط.
كما أنه لا إشكال في عدم الوهنية إذا كان إعتبارها من باب الظن النوعي.
وتوهم (جريان ما ذكرنا في القياس هنا من جهة أن النهي يدل على عدم كونه مؤثرا أصلا، فوجوده كعدمه من جميع الجهات)، مدفوع.
المقام الثالث: في الترجيح بالظن الغير المعتبر
وقد عرفت أنه على قمسين:
أحدهما ما ورد النهي عنه بالخصوص، كالقياس وشبهه.
والآخر ما لم يعتبر، لاجل عدم الدليل وبقائه تحت أصالة الحرمه.
القسم الاول: وهو الظن الذي ورد النهي عنه بالخصوص
أما الاول، فالظاهر من أصحابنا عدم الترجيح به.
نعم يظهر من المعارج وجود القول به بين أصحابنا، حيث قال في باب القياس: (ذهب ذاهب إلى أن الخبرين إذا تعارضا وكان القياس موافقا لما تضمنه أحدهما، كان ذلك وجها يقتضى ترجيح ذلك الخبر على معارضه.
ويمكن أن يحتج لذلك بأن الحق في أحد الخبرين، فلا يمكن العمل بهما ولا طرحهما، فتعين العمل بأحدهما.
وإذا كان التقدير تقدير التعارض، فلا بد في العمل باحدهما من مرجح، والقياس يصلح أن يكون مرجحا لحصول الظن به، فتعين العمل بما طابقه.
لا يقال: أجمعنا على أن القياس مطروح في الشريعة.
لانا نقول: بمعنى أنه ليس بدليل على الحكم، لا بمعنى أنه لا يكون مرجحا لاحد الخبرين على الآخر.
وهذا لان فائدة كونه مرجحا كونه رافعا للعمل بالخبر المرجوح، فيعود الراجح كالخبر السليم عن المعارض، فيكون العمل به، لا بذلك القياس، وفيه نظر)، إنتهى.
ومال إلى ذلك بعض سادة مشايخنا المعاصرين، قدست أسرارهم، بعض الميل والحق خلافه، لان رفع الخبر المرجوح بالقياس عمل به حقيقة، فإنه لولا القياس كان العمل به جائزا.
والمقصود تحريم العمل به، لاجل القياس، وأي عمل أعظم من هذا.والفرق بين المرجح
والدليل ليس إلا أن الدليل مقتض لتعين العمل به والمرجح رافع للمزاحم عنه.
فلكل منهما مدخل في العلة التامة لتعين العمل به.
فإذا كان إستعمال القياس محظورا وأنه لا يعبأ به في الشرعيات كان وجوده كعدمه غير مؤثر، مع أن مقتضى الاستناد في الترجيح به إلى إفادته للظن كونه من قبيل الجزء لمقتضي تعيين العمل، لا من قبيل دفع المزاحم، فيشترك مع الدليل المنضم إليه في الاقتضاء.هذا كله على مذهب غير القائلين بمطلق الظن.
وأما على مذهبهم: فيكون القياس تمام المقتضى بناء على كون الحجة عندهم الظن الفعلي، لان الخبر المنضم إليه ليس له مدخل في حصول الظن الفعلي بمضمونه.نعم قد يكون الظن مستندا إليهما فيصير من قبيل جزء المتقضي.
ويؤيد ما ذكرنا بل يدل عليه إستمرار سيرة أصحابنا الامامية، رضوان الله عليهم، في الاستنباط على هجره وترك الاعتناء بما حصل لهم من الظن القياسي أحيانا، فضلا عن أن يتوقفوا في التخيير بين الخبرين المعارضين مع عدم مرحج آخر أو الترجيح بمرجح موجود إلى أن يبحثوا عن القياس.
كيف ولو كان كذلك لاحتاجوا إلى عنوان مباحث القياس والبحث فيه بما يقتضي البحث عنها على تقدير الحجية.
وأما القسم الآخر وهو الظن الغير المعتبر، لاجل بقائه تحت أصالة حرمة العمل.فالكلام في الترجيح به يقع في مقامات.
الاول: الترجيح به في الدلالة بأن يقع التعارض بين ظهوري الدليلين، كما في العامين من وجه وأشباهه.
وهذا لا إختصاص له بالدليل الظني السند، بل يجري في الكتاب والسنة المتواترة.
الثاني: الترجيح به في وجه الصدور، بأن نفرض الخبرين صادرين وظاهري الدلالة، وانحصر التحير في تعيين ما صدر لبيان الحكم وتمييزه عما صدر على وجه التقية أو غيرها من الحكم المقتضية لبيان خلاف الواقع.
وهذا يجري في مقطوعي الصدور وفي مظنوني الصدور مع بقاء الظن بالصدور في كل منهما.
الثالث: الترجيح به من حيث الصدور بأن صار بالمرجح أحدهما مظنون الصدور.
أما المقام الاول [ وهو الترجيح بالظن الغير المتعبر في الدلالة ]
فتفصيل القول فيه: أنه إن قلنا بأن مطلق الظن على خلاف الظواهر يسقطها عن الاعتبار
لاشتراط حجيتها بعدم الظن على الخلاف، فلا إشكال في وجوب الاخذ بمقتضى ذلك الظن المرجح.
لكن يخرج حينئذ عن كونه مرجحا، بل يصير سببا لسقوط الظهور المقابل له عن الحجية، لا لدفع مزاحمته للظهور المنضم إليه، فيصير ما وافقه حجة سليمة عن المعارض.
إذ لو لم يكن في مقابل ذلك المعارض إلا هذا الظن لاسقطه عن الاعتبار.
نظير الشهرة في أحد الخبرين الموجبة لدخول الآخر في الشواذ التي لا إعتبار بها، بل أمرنا بتركها ولو لم يكن في مقابلها خبر معتبر.
وأولى من هذا: إذا قلنا بإشتراط حجية الظواهر بحصول الظن منها أو من غيرها على طبقها.
لكن هذا القول سخيف جدا.
والاول أيضا بعيد، كما حققناه في مسألة حجية الظواهر.
وإن قلنا بأن حجية الظواهر من حيث إفادتها للظن الفعلي وأنه لا عبرة بالظن الحاصل من غيرها على طبقها، أو قلنا بأن حجيتها من حيث الاتكال على أصالة عدم القرينة التي لا يعتبر فيها إفادتها للظن الفعلي، فالاقوى عدم إعتبار مطلق الظن في مقام الترجيح، إذ المفروض على هذين القولين سقوط كلا الظاهرين عن الحجية في مورد التعارض، فأنه إذا صدر عنه قوله، مثلا: إغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، وورد أيضا: كل شئ يطير لا بأس بخرئه وبوله، وفرض عدم قوة أحد الظاهرين من حيث نفسه على الاخر، كان ذلك مسقطا لظاهر كليهما عن الحجية في مادة التعارض، أعني خرء الطير الغير المأكول وبوله.
أما على القول الاول، فلان حجية الظواهر مشروطة بالظن المفقود في المقام.
وأما على الثاني، فلان أصالة عدم القرينة في كل منهما معارضة بمثلها في الآخر، والحكم في باب تعارض الاصلين مع عدم حكومة أحدهما على الاخر التساقط والرجوع إلى عموم أو أصل يكون حجيته مشروطا بعدم وجودهما على قابلية الاعتبار.
فلو عمل حينئذ بالظن الموجود مع أحدهما، كالشهرة القائمة في المسألة المذكورة على النجاسة، كنا قد عملنا بذلك الظن مستقلا، لا من باب كونه مرجحا، لفرض تساقط الظاهرين وصيرورتهما كالعدم.
فالمتجه حنيئذ الرجوع في المسألة، بعد الفراغ من المرجحات من حيث السند أو من حيث الصدور تقية أو لبيان الواقع، إلى قاعدة الطهارة.
القسم الثاني : وهو الترجيح بالظن الغير المعتبر في وجه الصدور
فتفصيل القول فيه أن اصالة عدم التقية - إن كان المستند فيها أصل العدم في كل حادث، بناء على أن دواعي التقية التي هي من قبيل الموانع لاظهار الحق حادثة - تدفع بالاصل، فالمرجع بعد
معارضة هذا الاصل في كل خبر بمثله في الاخر هو التساقط وكذلك لو إستندنا فيها إلى أن ظاهر حال المتكلم بالكلام، خصوصا الامام، عليه السلام، في مقام إظهار الاحكام التي نصب لاجلها هو بيان الحق، وقلنا بأن إعتبار هذا الظهور مشروط بإفادته الظن الفعلي المفروض سقوطه من الطرفين.
وحينئذ فإن عملنا بمطلق الظن في تشخيص التقية وخلافها - بناء على حجية الظن في هذا المقام، لاجل الحاجة إليه من جهة العلم بصدور كثير من الاخبار تقية وأن الرجوع إلى أصالة عدمها في كل مورد يوجب الافتاء بكثير مما صدر تقية، فتعين العمل بالظن، أو لانا نفهم مما ورد في ترجيح ماخالف العامة على ما وافقهم كون ذلك من أجل كون الموافقة مظنة للتقية، فتعين العمل بما هو أبعد عنها بحسب كل أمارة - كان ذلك الظن دليلا مستقلا في ذلك المقام وخرج عن كونه مرجحا.
ولو إستندنا فيها إلى الظهور المذكور واشترطنا في إعتباره عدم الظن على خلافه، كان الخبر الموافق لذلك الظن حجة سليمة عن المعارض لا عن المزاحم كما عرفت نظيره في المقام الاول.
وإن إستندنا فيها إلى الظهور النوعي، نظير ظهور فعل المسلم في الصحيح وظهور تكلم المتكلم في كونه قاصدا، لا هازلا، ولم يشترط في إعتباره الظن الفعلي ولا عدم الظن بالخلاف، تعارض الظاهران، فيقع الكلام في الترجيح بهذا الظن المفروض، والكلام فيه يعلم مما سيجئ.
أما المقام الثالث وهو ترجيح السند بمطلق الظن
فالكلام فيه أيضا مفروض فيما إذا لم نقل بحجية الظن المطلق ولا بحجية الخبرين بشرط إفادة الظن ولا بشرط عدم الظن على خلافه، إذ يخرج الظن المفروض على هذه التقادير عن المرجحية بل يصير حجة مستقلة على الاول، سواء كان حجية المتعارضين من باب الظن المطلق أو من باب الاطمينان أو من باب الظن الخاص، فإن القول بالظن المطلق لا ينافي القول بالظن الخاص في بعض الامارات كالخبر الصحيح بعدلين ويسقط المرجوح عن الحجية على الاخيرين، فيتعين أن الكلام في مرجحيته فيما إذا قلنا بحجية كل منهما من حيث الظن النوعي كما هو مذهب الاكثر.
والكلام يقع تارة في الترجيح بالظن في مقام لولاه لحكم بالتخيير وأخرى في الترجيح به في مقام المرجحات المنصوصة في الاخبار العلاجية.
أما الكلام في الاول وملخصه:
أنه لا ريب في أن مقتضى الاصل عدم الترجيح، كما أن الاصل عدم الحجية.
لان العمل بالخبر الموافق لذلك الظن إن كان على وجه التدين والالتزام بتعين العمل به من جانب الشارع وأن الحكم الشرعي الواقعي هو مضمونه، لا مضمون الاخر من غير دليل قطعي يدل على ذلك، فهو تشريع محرم بالادلة الاربعة، والعمل به لا على هذا الوجه محرم إذا إستلزم مخالفة القاعدة أو الاصل الذي يرجع إليه على تقدير فقد هذا الظن.
فالوجه المتقضي لتحريم العمل بالظن مستقلا من التشريع أو مخالفة الاصول القطعية الموجودة في المسألة جار بعينه في الترجيح بالظن والايات والاخبار الناهية عن القول بغير علم كلها متساوية النسبة إلى الحجية وإلى المرجحية.
وقد عرفت في الترجيح بالقياس أن المرجح يحدث حكما شرعيا لم يكن مع عدمه، وهو وجوب العمل بموافقته عينا، مع كون الحكم لا معه هو التخيير أو الرجوع إلى الاصل الموافق للاخر، هذا.
ولكن الذي يظهر من كلمات معظم الاصوليين هو الترجيح بمطلق الظن.
وليعلم أول أن محل الكلام، كما عرفت في عنوان المقامات الثلاثة أعني الجبر والوهن والترجيح، هو الظن الذي لم يعلم إعتباره.
فالترجح به من حيث السند أو الدلالة ترجيح بأمر خارجي.
وهذا لا دخل له بمسألة أخرى إتفاقية، وهي وجوب العمل بأقوى الدليلين وارجحهما.
فإن الكلام فيها في ترجيح أحد الخبرين الذي يكون بنفسه أقوى من الاخر من حيث السند، كالاعدل والافقه أو المسند أو الاشهر رواية أو غير ذلك، أو من حيث الدلالة، كالعام على المطلق، والحقيقة على المجاز، والمجاز على الاضمار، وغير ذلك.
وبعبارة أخرى، الترجيح بالمرجحات الداخلية من جهة النسد إتفاقي، واستفاض نقل الاجمع من الخاصة والعامة على وجوب العمل بأقوى الدليلين عن الاخر.
والكلام هنا في المرجحات الخارجية المعاضدة لمضمون أحد الخبرين الموجبة لصيرورة مضمونه اقرب إلى الواقع من مضمون الاخر.
نعم لو كشف تلك الامارة عن مزية داخلية لاحد الخبرين على الاخر من حيث سنده أو دلالته دخلت في المسألة الاتفاقية ووجب الاخذ بها، لان العمل بالراجح من الدليلين واجب إجماعا، سواء علم وجه الرجحان تفصيلا أم لم يعلم إلا إجمالا.
ومن هنا ظهر أن الترجيح بالشهرة والاجمع المنقول إذا كشفا عن مزية داخلية في سند أحد الخبرين أو دلالته مما لا ينبغي الخلاف فيه.
نعم لو لم يكشفا عن ذلك إلا ظنا، ففي حجيته أو
إلحاقه بالمرجح الخارجي وجهان، أقواهما الاول، كما سيجئ
* * *
وكيف كان فالذي يمكن أن يستدل به للترجيح بمطلق الظن الخارجي وجوه.
الاول: قاعدة الاشتغال، لدوران الامر بين التخيير وتعيين الموافق للظن.
وتوهم: (إنه قد يكوئن الطرف المخالف موافقا للاحتياط اللازم في المسألة الفرعية فيعارض الاحتياط في المسألة الاصولية بل يرجح عليه في مثل المقام، كما نبهنا عليه عند الكلام في معممات نتيجة دليل الانسداد)، مدفوع بأن المفروض فيما نحن فيه عدم وجوب الاخذ بما وافق الاحتياط من الخبرين لولا الظن: لان الاخذ به، إن كان من جهة إقتضاء المورد للاحتياط، فقد ورد عليه حكم الشارع بالتخيير المرخص للاخذ بخلاف الاحتياط وبراءة الذمة من الواقع في حكم الشارع بالعمل بالخبر المخالف له.
ولهذا يحكم بالتخيير أيضا وإن كان أحدهما موافقا للاستصحاب والاخر مخالفا، إذ كما أن الدليل المعين للعمل به يكون حاكما على الاصول، كذلك الدليل المخير في العمل به وبمعارضه.
وإن كان من جهه بعض الاخبار الدالة على وجوب الاخذ بما وافق الاحتياط وطرح ما خالفه، ففيه ما تقرر في محله من عدم نهوض تلك الاخبار لتخصيص الاخبار الدالة على التخيير.
بل هنا كلام آخر، وهو أن حجية الخبر المرجوح في المقام وجواز الاخذ به يحتاج إلى توقيف، إذ لا يكفي في ذلك ما دل على حجية كلا المتعارضين بعد فرض إمتناع العمل بكل منهما، فيجب الخذ بالمتيقن جواز العمل به وطرح المشكوك، وليس المقام مقام التكليف المردد بين التعيين والتخيير حتى يبنى على مسألة البراءة والاشتغال.
وتمام الكلام في خاتمة الكتاب في مبحث التراجيح إن شاء الله تعالى.
الثاني: ظهور الاجماع على ذلك، كما إستظهره بعض مشايخنا، فتراهم يستدلون في موارد الترجيح ببعض المرجحات الخارجية بإفادته للظن بمطابقة أحد الدليلين للواقع، فكان الكبرى وهي وجوب الاخذ بمطلق ما يفيد الظن على طبق أحد الدليلين مسلمة عندهم.
وربما يستفاد ذلك من الاجماعات المستفيضة على وجوب الاخذ بأقوى المتعارضين.
إلا أنه يشكل بما ذكرنا: من أن الظاهر أن المراد بأقوى الدليلين منهما ما كان كذلك في نفسه ولو إنكشف أمر خارجي عن ذلك، كعمل الاكثر الكاشف عن مرجح داخلي لا نعلمه تفصيلا، فلا يدخل فيه ما كان مضمونه مطابقا لامارة غير معتبرة، كالاستقراء والاولوية الظنية مثلا، على تقدير عدم إعتبارهما، فإن الظاهر خروج ذلك
عن معتقد تلك الاجماعات، وإن كان بعض أدلتهم ألاخر قد يفيد العموم لما نحن فيه، كقبح ترجيح المرجوح، إلا أنه لا يبعد أن يكون المراد المرجوح في نفسه من المتعارضين لا مجرد المرجوح بحسب الواقع، وإلا إقتضى ذلك حجية نفس المرجح مستقلا.
نعم الانصاف: أن بعض كلماتهم يستفاد منه أن العبرة في الترجيح بصيرورة مضمون أحد الخبرين بواسطة المرجح أقرب إلى الواقع من مضمون الآخر.
وقد إستطهر بعض مشايخنا الاتفاق على الترجيح بكل ظن ما عدا القياس.
فمنها: ما تقدم عن المعارج من الاستدلال للترجيح بالقياس بكون مضمون الخبر الموافق له أقرب إلى الواقع من مضمون الاخر.
ومنها: ما ذكروه في مسائل تعارض الناقل مع المقرر، فإن مرجع ما ذكروا فيها لتقديم أحدهما على الاخر إلى الظن بموافقة احدهما لحكم الله الواقعي.
إلا أن يقال: إن هذا الظن حاصل من نفس الخبر المتصف بكونه مقررا أو ناقلا.
ومنها: ما ذكروه في ترجيح أحد الخبرين بعمل أكثر السلف معللين بأن الاكثر يوفق للصواب بما لا يوافق له الاقل، وفي ترجيحه بعمل علماء المدينة، إلا أن يقال أيضا: إن ذلك كاشف عن مرجح داخلي في احد الخبرين.
وبالجملة فتتبع كلماتهم يوجب الظن القوي بل القطع بأن بناءهم على الاخذ بكل ما يشمل على ما يوجب اقربيته إلى الصواب، سواء كان لامر راجع إلى نفسه أو لاحتفافه بأمارة أجنبية توجب قوة مضمونها.
ثم لو فرض عدم حصول القطع من هذه الكلمات بمرجحية الظن المطلق المطابق لمضمون أحد الخبرين، فلا أقل من كونه مظنونا، والظاهر وجوب العمل به في مقابل التخيير وإن لم يجب العمل به في مقابل الاصول.
وسيجئ بيان ذلك إن شاء الله تعالى.
الثالث: ما يظهر من بعض الاخبار، من أن المناط في الترجيح كون أحد الخبرين أقرب مطابقة للواقع، سواء كان لمرجح داخلي كالاعدلية مثلا أو لمرجح خارجي كمطابقته لامارة توجب كون مضمونه أقرب إلى الواقع من مضمون الاخر: مثل ما دل على الترجيح بالاصدقية في الحديث، كما في مقبولة إبن حنظلة، فإنا نعلم أن وجه الترجيح بهذه الصفة ليس إلا كون الخبر الموصوف بها أقرب إلى الواقع من الخبر الغير الوصوف بها، لا لمجرد كون راوي أحدهما أصدق.وليس هذه الصفة مثل الاعدلية وشبهها في إحتمال كون العبرة
بالظن الحاصل من جهتها بالخصوص.
ولذا اعتبر الظن الحاصل من عدالة البينة دون الحاصل من مطلق الوثاقة، لان صفة الصدق ليست إلا المطابقة للواقع.فمعنى الاصدق هو الاقرب إلى الواقع.فالترجيح بها يدل على أن العبرة بالاقربية من أي سبب حصلت.
ومثل ما دل على ترجيح أوثق الخبرين، فإن معنى الاوثقية شدة الاعتماد عليه، وليس إلا لكون خبره أوثق.
فإذا حصل هذا المعنى في أحد الخبرين من مرجح خارجي اتبع.
ومما يستفاد منه المطلب على وجه الظهور ما دل على ترجيح أحد الخبرين على الاخر بكونه مشهورا بين الاصحاب بحيث يعرفه كلهم وكون الاخر غير مشهور الرواية بينهم، بل ينفرد بروايته بعضهم دون بعض، معللا ذلك بأن المجمع عليه لا ريب فيه، فيدل على أن طرح الاخر لاجل ثبوت الريب فيه، لا لانه لا ريب في بطلانه، كما قد يتوهم، وإلا لم يكن معنى للتعارض وتحير السائل، ولا لتقديمه على الخبر المجمع عليه، إذا كان راويه أعدل كما يقتضيه صدر الخبر، ولا لقول السائل بعد ذلك: (هما مشهوران معا).
فحاصل المرجح هو ثبوت الريب في الخبر الغير المشهور وإنتفاؤه في المشهور، فيكون المشهور من الامر البين الرشد، وغيره من الامر المشكل، لا بين الغي، كما توهم.
وليس المراد به نفي الريب من جميع الجهات، لان الاجماع على الرواية لا يوجب ذلك ضرورة، بل المراد وجود ريب في غير المشهور يكون منتفيا في الخبر المشهور، وهو احتمال وروده على بعض الوجوه أو عدم صدوره رأسا.
وليس المراد بالريب مجرد الاحتمال ولو موهوما، لان الخبر المجمع عليه يحتمل فيه أيضا من حيث الصدور بعض الاحتمالات المتطرقة في غير المشهور، غاية الامر كونه في المشهور في غاية الضعف بحيث يكون خلافه واضحا في غير المشهور إحتمالا مساويا يصدق عليه الريب عرفا.
وحينئذ فيدل على رجحان كل خبر يكون نسبته إلى معارضه مثل نسبة الخبر المجمع على روايته إلى الخبر الذي اختص بروايته بعض دون بعض، مع كونه بحيث لو سلم عن المعارض أو كان روايه أعدل وأصدق من راوي معارضه المجمع عليه لاخذ به،، ومن المعلوم أن الخبر المعتضد بأمارة توجب الظن بمطابقته ومخالفة معارضه للواقع نسبته إلى معارضه تلك النسبة.
ولعله لذا عللل تقديم الخبر المخالف للعامة على الموافق بأن ذاك لا يحتمل إلا الفتوى وهذا يحتمل التقية، لان الريب الموجود في الثاني منتف في الاول.
وكذا كثير من المرجحات الراجعة إلى وجود إحتمال في أحدهما مفقود علما أو ظنا في الاخر، فتدبر.
فكل خبر من المتعارضين يكون فيه ريب لا يوجد في الاخر أو يوجد ولا يعد لغاية ضعفه ريبا، فذاك الاخر مقدم عليه.
واظهر من ذلك كله، في إفادة الترجيح بمطلق الظن، ما دل من الاخبار العلاجية على الترجيح بمخالفة العامة، بناء على أن الوجه في الترجيح بها أحد وجهين: أحدهما: كون الخبر المخالف أبعد من التقية، كما علل به الشيخ والمحقق.
فيستفاد منه إعتبار كل قرينة خارجية توجب أبعدية أحدهما عن خلاف الحق ولو كانت مثل الشهرة والاستقراء، بل يستفاد منه عدم إشتراط الظن في الترجيح، بل يكفي تطرق إحتمال غير بعيد في أحد الخبرين بعيد في الاخر، كما هو مفاد الخبر المتقدم الدال على ترجيح ما لا ريب فيه على ما فيه الريب بالنسبة إلى معارضه.
لكن هذا الوجه لم ينص عليه في الاخبار، وإنما هو شئ مستنبط منها، ذكره الشيخ ومن تأخر عنه.
نعم في رواية عبيد بن زرارة: (ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه)، دلالة على ذلك.
الثاني: كون الخبر المخالف أقرب من حيث المضمون إلى الواقع.
والفرق بين الوجهين: أن الاول كاشف عن وجه صدور الخبر، والثاني كاشف عن مطابقة مضمون أحدهما للواقع.
وهذا الوجه لما نحن فيه منصوص في الاخبار، مثل تعليل الحكم المذكور فيها بقولهم عليهم السلام: (فإن الرشد في خلافهم)، وما (ما خالف العامة ففيه الرشاد).
فإن هذه القضيه قضيه غالبية لا دائمية، فيدل على أنه يكفي في الترجيح الظن بكون الرشد في مضمون أحد الخبرين.
ويدل على هذا التعليل أيضا ما ورد في صورة عدم وجدان المفتي بالحق في بلد، من قوله: (إئت فقيه البلد فاستفته في أمرك، فإذا أفتاك بشئ فخذ بخلافه، فإن الحق فيه).
وأصرح من الكل في التعليل بالوجه المذكور مرفوعة أبي إسحاق الارجاني إلى أبي عبدالله عليه السلام.
قال: قال عليه السلام: (أتدري لم أمرتم بالاخذ بخلاف ما يقوله العامة؟ فقلت: لا أدري: فقال: إن عليا، عليه السلام، لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الامة إلى غيره، إرادة لابطال أمره، وكانوا يسألون أمير المؤمنين، عليه السلام، عن الشئ الذي لا يعلمونه، فإذا أفتاهم بشئ جعلوا له ضدا من عند أنفسهم ليلبسوا على الناس).
ويصدق هذا الخبر سيرة أهل الباطل مع الائمة، عليهم السلام، على هذا النحو، تبعا لسلفهم.
حتى أن أبا حنيفة حكي عنه أنه قال: (خالفت جعفرا في كل ما يقول أو يفعل، لكني لا أدري هل يغمض عينيه في الركوع والسجود أو يفتحهما).
والحاصل: أن تعليل الاخذ بخلاف العامة في هذه الروايات بكونه أقرب إلى الواقع، حتى أنه يجعل دليلا مستقل عند فقد من يرجع إليه في البلد، ظاهر في وجوب الترجيح بكل ما هو من قبيل هذه الامارة في كون مضمونه مظنة الرشد.
فإذا إنضم هذا الظهور إلى الظهور الذي ادعيناه في روايات الترجيح بالاصدقية والاوثقية، فالظاهر أنه يحصل من المجموع دلالة لفظية تامة.
ولعل هذا الظهور المحصل من مجموع الاخبار العلاجية هو الذي دعى أصحابنا إلى العمل بكل ما يوجب رجحان احد الخبرين على الاخر، بل يوجب في أحدهما مزية مفقودة في الاخر ولو بمجرد كون خلاف الحق في احدهما أبعد منه في الاخر، كما هو كذلك في كثير من المرجحات.
فما ظنه بعض المتأخرين من أصحابنا على العلامة وغيره، قدست أسرارهم، من متابعتهم في ذلك طريقة العامة ظن في غير المحل.
ثم إن الاستفادة التي ذكرناها إن دخلت تحت الدلالة اللفظيه، فلا إشكال في الاعتماد عليها، وإن لم يبلغ هذا الحد بل لم يكن إلا مجرد الاشعار، كان مؤيدا لما ذكرنا من ظهور الاتفاق.
فإن لم يبلغ المجموع حد الحجية فلا أقل من كونها أمارة مفيدة للظن بالمدعى.
ولا بد من العمل به، لان التكليف بالترجيح بين المتعارضين ثابت، لان التخيير في جميع الموارد وعدم ملاحظة المرجحات يوجب مخالفة الواقع في كثير من الموارد، لانا نعلم بوجوب الاخذ ببعض الاخبار المتعارضة وطرح بعضها معينا.والمرجحات المنصوصة في الاخبار غير وافية.
مع أن تلك الاخبار معارض بعضها بعضها، بل بعضها غير معمول به بظاهره، كمقبولة إبن حنظلة المتضمنة لتقديم الاعدلية على الشهرة ومخالفة العامة وموافقة الكتاب.
وحاصل هذا المقدمات: ثبوت التكليف بالترجيح وإنتفاء المرجح اليقيني وإنتفاء ما دل الشرع على كونه مرجحا، فينحصر العمل في الظن بالمرجح.
فكل ما ظن أنه مرجح في نظر الشارع وجب الترجيح به، وإلا لوجب ترك الترجيح أو العمل بما ظن من المتعارضين أن الشارع يرجح غيره عليه.
والاول مستلزم للعمل بالتخيير في موارد كثيرة نعلم التكليف بوجوب الترجيح، والثاني ترجيح للمرجوح على الراجح في مقام وجوب البناء على أحدهما، لاجل تعذر العلم على أحدهما وقبحه بديهي.
وحينئذ فإذا ظننا من الامارات السابقة أن مجرد أقربية مضمون أحد الخبرين إلى الواقع مرجح في نظر الشارع تعين الاخذ به، هذا.
ولكن لمانع أن يمنع وجوب الترجيح بين المتعارضين الفاقدين للمرجحات المعلومة، كالتراجيح الراجعة إلى الدلالة التي دل العرف على وجوب الترجيح بها، كتقديم النص والاظهر على الظاهر.
بيان ذلك: أن ما كان من المتعارضين من قبيل النص والظاهر، كالعام والخاص وشبههما مما لا يحتاج الجمع بينهما إلى شاهد، فالمرجح فيه معلوم من العرف.
وما كان من قبيل تعارض الظاهرين، كالعامين من وجه وشبههما مما يحتاج الجميع بينهما إلى شاهد واحد، فالوجه فيه، كما عرفت سابقا، عدم الترجيح إلا بقوة الدلالة، لا بمطابقة أحدهما لظن خارجي غير معتبر، ولذا لم يحكم فيه بالتخيير مع عدم ذلك الظن، بل يرجع فيه إلى الاصول والقواعد.
فهذا كاشف عن أن الحكم فيهما ذلك من أول الامر للتساقط، لاجمال الدلالة.
وما كان من قبيل المتباينين اللذين لا يمكن الجمع بينهما إلا بشاهدين، فهذا هو المتيقن من مورد وجوب الترجيح بالمرجحات الخارجية.
ومن المعلوم أن موارد هذا التعارض على قسمين:
أحدهما ما يمكن الرجوع فيه إلى أصل أو عموم كتاب أو سنة مطابق لاحدهما.وهذا القسم يرجع فيه إلى ذلك العموم أو الاصل.
وإن كان الخبر المخالف لاحدهما مطابقا لامارة خارجية - وذلك لان العمل بالعموم والاصل يقيني لا يرفع اليد عنه إلا بوارد يقيني، والخبر المخالف له لا ينهض لذلك، لمعارضته بمثله، والمفروض أن وجوب الترجيح بذلك الظن لم يثبت - فلا وارد على العموم والاصل.
القسم الثاني: ما لا يكون كذلك.وهذا أقل قليل بين المتعارضات.
فلو فرضنا العمل فيه بالتخيير مع وجود ظن خارجي على طبق أحدهما لم يكن محذور.
نعم الاحتياط يقتضي الاخذ بما يطابق الظن خصوصا، مع أن مبنى المسألة على حجية الخبر من باب الظن غير مقيد بعدم الظن الفعلي على خلافه.
والدليل على هذا الاطلاق مشكل، خصوصا لو كان الظن المقابل من الشهرة المحققة أو نقل الاجماع الكاشف عن تحقق الشهرة، فإن إثبات حجية الخبر المخالف للمشهور في غاية الاشكال وإن لم نقل بحجية الشهرة.
ولذا قال صاحب المدارك: (إن العمل بالخبر المخالف للمشهور مشكل، وموافقة الاصحاب من غير دليل أشكل).
وبالجملة فلا ينبغي ترك الاحتياط بالاخذ بالمظنون في مقابل التخيير.
وأما في مقابل العمل بالاصل، فإن كان الاصل مثبتا للاحتياط، كالاحتياط اللازم في بعض الموارد، فالاحوط العمل بالاصل.
وإن كان نافيا للتكليف كأصل البراءة والاستصحاب النافي للتكليف، أو مثبتا له مع عدم التمكن من الاحتياط كأصالة الفساد في باب المعاملات ونحو ذلك، ففيه الاشكال.
وفي باب التراجيح تتمة المقال، والله العالم بحقيقة الحال، والحمد لله أولا وآخرا.
وصلى الله على محمد وآله باطنا وظاهرا.
المقصد الثالث من مقاصد الكتاب في الشك
[ مقدمة ]
قد قسمنا، في صدر هذا الكتاب، المكلف الملتفت إلى الحكم الشرعي العملي في الواقعة على ثلاثة أقسام، لانه إما أن يحصل له القطع بحكمه الشرعي، وإما أن يحصل له الظن، وإما أن يحصل له الشك.
وقد عرفت أن القطع حجة في نفسه لا بجعل جاعل، والظن يمكن أن يعتبر في متعلقه، لكونه كشفا ظنيا ومرآة لمتعلقه.
لكن العمل به والاعتماد عليه في الشرعيات موقوف على وقوع التعبد به، وهو غير واقع إلا في الجملة.
وقد ذكرنا موارد وقوعه في الاحكام الشرعية في الجزء الاول من هذا الكتاب.
وأما الشك، فلما لم يكن فيه كشف أصلا لم يعقل فيه أن يعتبر.
فلو ورد في مورده حكم شرعي، كأن يقول: (الواقعة المشكوكة حكمها كذا)، كان حكما ظاهريا، لكونه مقابلا للحكم الواقعي المشكوك بالفرض.
ويطلق عليه الواقعي الثانوي أيضا، لانه حكم واقعي للواقعة المشكوك في حكمها، وثانوي بالنسبة إلى ذلك الحكم المشكوك فيه، لان موضوع هذا الحكم الظاهري، وهي الواقعة المشكوك في حكمها، لا يتحقق إلا بعد تصور حكم نفس الواقعة والشك فيه.مثلا شرب التتن في نفسه له حكم، فرضنا فيما نحن فيه شك المكلف فيه.
فإذا فرضنا ورود حكم شرعي لهذا الفعل المشكوك الحكم كان هذا الحكم الوارد متأخرا طبعا عن ذلك المشكوك.
فذلك الحكم حكم واقعي بقول مطلق، وهذا الوارد ظاهري، لكونه المعمول به في الظاهر، وواقعي ثانوي، لانه متأخر عن ذلك الحكم، لتأخر موضوعه عنه، ويسمى الدليل الدال على هذا الحكم الظاهري أصلا.
وأما ما دل على الحكم الاول علما أو ظنا معتبرا، فيختص باسم الدليل، وقد يقيد بالاجتهادي.
كما أن الاول قد يسمى بالدليل مقيدا بالفقاهتي.
وهذان القيدان إصطلاحان من الوجيد البهبهاني، لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه والاجتهاد.
ثم إن الظن الغير المعتبر حكمه حكم الشك، كما لا يخفى.
ومما ذكرنا - من تأخر مرتبة الحكم الظاهرى عن الحكم الواقعي، لاجل تقييد موضوعه بالشك في الحكم الواقعي، يظهر لك وجه تقديم الادلة على الاصول، لان موضوع الاصول يرتفع بوجود الدليل.
فلا معارضة بينهما، لا لعدم إتحاد الموضوع، بل لارتفاع موضوع الاصل - وهو الشك - بوجود الدليل.
ألا ترى أنه لا معارضة ولا تنافي بين كون حكم شرب التتن المشكوك حكمه هي الاباحة وبين كون حكم شرب التتن في نفسه مع قطع النظر عن الشك فيه هي الحرمة.
فإذا علمنا بالثاني لكونه علميا ونفرض سلامته عن معارضة الاول، خرج شرب التتن عن موضوع دليل الاول، وهو كونه مشكوك الحكم، لا عن حكمه حتى يلتزم فيه تخصيص وظرح لظاهره.
ومن هنا كان إطلاق التقديم والترجيح في المقام تسامحا، لان الترجيح فرع المعارضة.
وكذلك إطلاق الخاص على الدليل والعام على الاصل، فيقال يخصص الاصل بالدليل او يخرج عن الاصل بالدليل.
ويمكن أن يكون هذا الاطلاق على الحقيقة بالنسبة إلى الادلة الغير العلمية، بأن يقال: إن مؤدى أصل البراءه، مثلا، أنه إذا لم يعلم حرمة شرب التتن فهو غير محرم، وهذا عام ومفاد الدليل الدال على إعتبار تلك الامارة الغير العلمية المقابلة للاصل إنه إذا قام تلك الامارة الغير العلمية على حرمة الشئ الفلاني فهو حرام.
وهذا أخص من دليل أصل البراءة مثلا، فيخرج عنه به.
وكون دليل تلك الامارة أعم من وجه، بإعتبار شموله لغير مورد أصل البراءة، لا ينفع بعد قيام الاجماع على عدم الفرق في إعتبار تلك الامارة بين مواردها.
وتوضيح ذلك: أن كون الدليل رافعا لموضوع الاصل - وهو الشك - إنما يصح في الدليل العلمي، حيث أن وجوده يخرج حكم الواقعة عن كونه مشكوكا فيه.
وأما الدليل الغير العلمي فهو بنفسه غير رافع لموضوع الاصل، وهو عدم العلم.
وأما الدليل الدال على إعتباره، فهو وإن كان علميا إلا أنه لا يفيد إلا حكما ظاهريا نظير مفاد الاصل.
إذ المراد بالحكم الظاهري ما ثبت لفعل المكلف بملاحظة الجهل بحكمه الواقعي الثابت له من دون مدخلية العلم والجهل.
فكما أن مفاد قوله عليه السلام: (كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي)، يفيد الرخصة في الفعل الغير المعلوم ورود النهي فيه، فكذلك ما دل على حجية الشهرة الدالة مثلا على وجوب شئ، يفيد وجوب ذلك الشئ من حيث أنه مظنون مطلقا أو بهذه الامارة.
ولذا إشتهر أن علم المجتهد بالحكم مستفاد من صغرى وجدانية، وهي: (هذا ما أدى إليه ظني)، وكبرى برهانية، وهي: (كل ما أدى إليه ظني فهو حكم الله في حقي).فإن الحكم المعلوم منهما هو الحكم الظاهري.
فإذا كان مفاد الاصل ثبوت الاباحة للفعل الغير المعلوم الحرمة، ومفاد دليل تلك الامارة ثبوت الحرمة للفعل المظنون الحرمة، كانا متعارضين لا محالة.
فإذا بني على العمل بتلك الامارة، كان فيه خروج عن عموم الاصل وتخصيص له لا محالة، هذا.
ولكن التحقيق أن دليل تلك الامارة وإن لم يكن كالدليل العلمى رافعا لموضوع الاصل، إلا أنه نزل شرعا منزلة الرافع، فهو حاكم على الاصل لا مخصص له، كما سيتضح إن شاء الله.
على أن ذلك إنما يتم بالنسبة إلى الادلة الشرعية.
وأما الادلة العقلية القائمة على البراءة والاشتغال، فإرتفاع موضوعها بعد ورود الادلة الظنية واضح، لجواز الاقتناع بها في مقام البيان وإنتهاضها رافعا لاحتمال العقاب، كما هو ظاهر.وأما التخيير فهو أصل عقلي لا غير.
واعلم أن المقصود بالكلام في هذه الرسالة الاصول المتضمنة لحكم الشبهة في الحكم الفرعي الكلي وإن تضمنت حكم الشبهة في الموضوع أيضا.
وهي منحصرة في أربعة، أصل البراءة وأصل الاحتياط والتخيير والاستصحاب، بناء على كونه حكما ظاهريا ثبت التعبد به من الاخبار، إذ بناء على كونه مفيدا للظن يدخل في الامارات الكاشفة عن الحكم الواقعي.
وأما الاصول المشخصة لحكم الشبهة في الموضوع، كأصالة الصحة وأصالة الوقوع فيما شك فيه بعد تجاوز المحل، فلا يقع الكلام فيها إلا لمناسبة يقتضيها المقام.
ثم إن إنحصار موارد الاشتباه في الاصول الاربعة عقلي لان حكم الشك إما أن يكون ملحوظا فيه اليقين السابق عليه، وإما أن لا يكون، سواء لم يكن يقين سابق عليه أم كان ولم يلحظ.
والاول مورد الاستصحاب.
والثاني إما أن يكون الاحتياط فيه ممكنا أم لا، والثانى مورد
التخيير.
والاول إما أن يدل دليل عقلي أو نقلي على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول وإما أن لا يدل.
والاول مورد الاحتياط، والثاني مورد البراءة.
وقد ظهر مما ذكرنا أن موارد الاصول قد تتداخل، لان المناط في الاستصحاب ملاحظة الحالة المتيقنة السابقة، ومدار الثلاثة الباقية على عدم ملاحظتها وإن كانت موجودة.
ثم إن تمام الكلام في الاصول الاربعه يحصل بإشباعه في مقامين: أحدهما: حكم الشك في الحكم الواقعى من دون ملاحظة الحالة السابقة الراجع إلى الاصول الثلاثة.
الثاني: حكمه بملاحظة الحالة السابقة وهو الاستصحاب.
* * *
المقام الاول : وهو حكم الشك في الحكم الواقعي
[ من دون ملاحظة الحالة السابقة ] فيقع الكلام فيه في موضعين، لان الشك إما في نفس التكليف، وهو النوع الخاص من الالزام وإن علم جنسه، كالتكليف المردد بين الوجوب والتحريم.
وإما في متعلق التكليف مع العلم بنفسه، كما إذا علم وجوب شئ وشك بين تعلقه بالظهر والجمعة، أو علم وجوب فائتة وتردد بين الظهر والمغرب.
الموضع الاول: وهو الشك في نفس التكليف
يقع الكلام فيه في مطالب، لان التكليف المشكوك فيه إما تحريم مشتبه بغير الوجوب، وإما وجوب مشتبه بغير التحريم، وإما تحريم مشتبه بالوجوب، [ لان التكليف المشكوك فيه إما إيجاب مشتبه بغيره وإما تحريم كذلك، ص ]، وصور الاشتباه كثيرة.
وهذا مبني على إختصاص التكليف بالالزام أو إختصاص الخلاف في البراءة والاحتياط به، فلو فرض شموله للمستحب والمكروه يظهر حالهما من الواجب والحرام، فلا حاجة إلى تعميم العنوان.
ثم متعلق التكليف المشكوك: إما أن يكون فعلا كليا متعلقا للحكم الشرعي الكلي، كشرب التتن المشكوك في حرمته، والدعاء عند رؤية الهلال المشكوك في وجوبه.
وإما أن يكون فعلا جزئيا متعلقا للحكم الجزئي، كشرب هذا المائع المحتمل كونه خمرا.
ومنشأ الشك في القسم الثاني إشتباه الامور الخارجية.
ومنشاؤه في الاول إما عدم النص في المسألة، كمسألة شرب التتن، وإما أن يكون إجمال النص، كدوران الامر في قوله تعالى: (حتى يطهرن)، بين التشديد والتخفيف مثلا، وإما أن يكون تعارض النصين.
ومنه الاية المذكورة بناء على تواتر القراءات.
وتوضيح أحكام هذه الاقسام في ضمن مطالب: الاول: دوران الامر بين الحرمة وغير الوجوب من الاحكام الثلاثة الباقية.
الثاني: دوران الامر بين الوجوب وغير التحريم.
الثالث: دورانه بين الوجوب والتحريم.
المطلب الاول: فيما دار الامر فيه بين الحرمة وغير الوجوب
وقد عرفت أن متعلق الشك، تارة، الواقعة الكلية، كشرب التتن.
ومنشأ الشك فيه عدم النص أو إجماله أو تعارضه، وأخرى، الواقعة الجزئية.
فههنا أربع مسائل:
[ المسألة ] الاولى: ما لا نص فيه وقد إختلف فيه على ما يرجع إلى قولين:
أحدهما إباحة الفعل شرعا وعدم وجوب الاحتياط بالترك.
والثاني وجوب الترك ويعبر عن الاحتياط.
والاول منسوب إلى المجتهدين.
والثاني إلى معظم الاخباريين.
وربما نسب إليهم أقوال أربعة: التحريم ظاهرا، والتحريم واقعا، والتوقف، والاحتياط.
ولا يبعد أن يكون تغايرها بإعتبار العنوان.
ويحتمل الفرق بينها وبين بعضها من وجه أخر تأتي بعد ذكر أدلة الاخباريين.
احتج للقول الاول بالادلة الاربعة فمن الكتاب آيات: منها: قوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها).
قيل: دلالتها واضحة.
وفيه: أنها غير ظاهرة، فإن حقيقة الايتاء إلاعطاء.
فاما أن يراد بالموصول المال، بقرينة قوله تعالى قبل ذلك: (من قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله).
فالمعنى: أن الله سبحانه لا يكلف العبد إلا دفع ما أعطي من مال.وإما أن يراد نفس فعل الشئ أو تركه، بقرينة إيقاع التكليف عليه.
فإعطاؤه كناية عن الاقدار عليه، فتدل على نفي التكليف بغير المقدور، كما ذكره الطبرسي، رحمه الله.
وهذا المعنى أظهر وأشمل، لان الانفاق من الميسور داخل في ما آتاه الله.وكيف كان.
فمن المعلوم أن ترك ما يحتمل التحريم ليس غير مقدور، وإلا لم ينازع في وقوع التكليف به أحد من المسلمين وإن نازعت الاشاعرة في إمكانه.
نعم لو أريد من الموصول نفس الحكم والتكليف كان إيتاؤه عبارة عن الاعلم به.
لكن إرادته بالخصوص تنافي مورد الاية، وإرادة الاعم منه ومن المورد تستلزم إستعمال الموصول في معنيين، إذا لا جامع بين تعلق التكليف بنفس الحكم وبالفعل المحكوم عليه، فافهم.
نعم في رواية عبدالاعلى عن أبي عبدالله عليه السلام: (قال: قلت له: هل كلف الناس بالمعرفة؟ قال: لا، على الله البيان.لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها).
لكنها لا تنفع في المطلب، لان نفس المعرفة بالله غير مقدور قبل تعريف الله سبحانه، فلا يحتاج دخولها في الاية إلى إرادة الاعلام من الايتاء في الاية.وسيجئ زيادة توضيح لذلك في ذكر الدليل العقلي إن شاء الله تعالى.
ومما ذكرنا يظهر حال التمسك بقوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها).
ومنها: قوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا).
بناء على أن بعث الرسول كناية عن بيان التكليف، لانه يكون به غالبا، كما في قولك: (لا أبرح من هذا المكان حتى يؤذن المؤذن)، كناية عن دخول الوقت أو عبارة عن البيان النقلي.
ويخصص العموم بغير المستقلات أو يلتزم بوجوب التأكيد وعدم حسن العقاب إلا مع اللطف بتأييد العقل بالنقل وإن حسن الذم، بناء على أن منع اللطف يوجب قبح العقاب دون الذم، كما صرح به البعض.
وعلى أي تقدير فتدل على نفي العقاب قبل البيان.
وفيه: أن ظاهرها الاخبار بوقوع التعذيب سابقا بعد البعث، فيختص بالعذاب الدنيوى الواقع في الامم السابقة.
ثم إنه ربما يورد التناقض على من جمع بين التمسك بالاية في المقام وبين رد من إستدل بها، لعدم الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع بأن نفي فعلية التعذيب أعم من نفي الاستحقاق به، فإن الاخبار بنفي التعذيب إن دل على عدم التكليف شرعا فلا وجه للثاني، وإن لم يدل فلا وجه للاول.
ويمكن دفعه: بأن عدم الفعلية يكفي في هذا المقام، لان الخصم يدعي أن في إرتكاب الشبهة الوقوع في العقاب والهلاك فعلا من حيث لا يعلم، كما هو مقتضى رواية التثليث ونحوها التي هي عمدة أدلتهم، ويعترف بعدم المقتضى للاستحقاق على تقدير عدم الفعلية، فيكفي في عدم الاستحقاق نفي الفعلية، بخلاف مقام التكلم في الملازمة، فإن المقصود فيه إثبات الحكم الشرعي في مورد حكم العقل، وعدم ترتب العقاب على مخالفته لا ينافي ثبوته، كما في الظهار، حيث قيل إنه محرم معفو عنه.وكما في العزم على المعصية على إحتمال.
نعم لو فرض هناك أيضا إجماع على أنه لو إنتفت الفعلية إنتفى الاستحقاق، كما يظهر من بعض ما فرعوا على تلك المسألة، لم يجز التمسك به هناك.
والانصاف: أن الاية لا دلالة لها على المطلب في المقامين.
ومنها: قوله تعالى: (وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون)،
أي: ما يجتنبونه من الافعال والتروك.وظاهرها أنه تعالى لا يخذلهم بعد هدايتهم إلى الاسلام إلا بعدما يبين لهم.
وعن الكافي وتفسير العياشى وكتاب التوحيد: (حتى يعرفهم ما يرضيه وما يسخطه).
وفيه: ما تقدم في الاية السابقة، مع أن دلالتها أضعف.
من حيث أن توقف الخذلان على البيان غير ظاهر الاستلزام للمطلب، اللهم إلا بالفحوى.
ومنها: قوله تعالى: (ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة).وفي دلالتها تأمل ظاهر.
ويرد على الكل أن غاية مدلولها عدم المؤاخذة على مخالفة النهي المجهول عند المكلف لو فرض وجوده واقعا، فلا ينافي ورود الدليل العام على وجوب إجتناب ما يحتمل التحريم.ومعلوم أن القائل بالاحتياط ووجوب الاجتناب لا يقول به إلا عن دليل علمي.
وهذه الايات بعد تسليم دلالتها غير معارضة لذلك الدليل، بل هي من قبيل الاصل بالنسبة إليه، كما لا يخفى.
ومنها: قوله تعالى، مخاطبا لنبيه، صلى الله عليه وآله، ملقنا إياه طريق الرد على اليهود، حيث حرموا بعض ما رزقهم الله تعالى إفتراء عليه: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا).
فأبطل [ تشريعهم ] بعدم وجدان ما حرموه في جملة المحرمات التي أوحى الله إليه.
وعدم وجدانه " ص " ذلك فيما أوحي إليه وإن كان دليلا قطعيا على عدم الوجود إلا أن في التعبير بعدم الوجدان دلالة على كفاية عدم الوجدان في إبطال الحكم بالحرمة.
لكن الانصاف: أن غاية الامر ان يكون في العدول عن التعبير بعدم الوجود إلى عدم الوجدان إشارة إلى المطلب.
وأما الدلالة فلا، ولذا قال في الوافية: (وفي الاية إشعار بأن إباحة الاشياء مركوزة في العقل قبل الشرع).
مع أنه لو سلم، فغاية مدلولها كوه عدم وجدان التحريم فيما صدر عن الله تعالى من الاحكام يوجب عدم التحريم، لا عدم وجدانه فيما بقي بأيدينا من احكام الله تعالى بعد العلم بإختفاء كثير منها عنا، وسيأتي توضيح ذلك عند الاستدلال بالاجماع العملي على هذا المطلب.
ومنها: قوله تعالى: (وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم).
يعني مع خلو ما فصل عن ذكر هذا الذي يجتنبونه.
ولعل هذه الاية أظهر من سابقتها، لان السابقة دلت على أنه لا يجوز الحكم بحرمة ما لم يوجد تحريمه فيما أوحى الله سبحانه إلى النبي، صلى الله عليه وآله.
وهذه تدل على أنه لا يجوز إلتزام ترك الفعل مع عدم وجوده فيما فصل وإن لم يحكم بحرمته فيبطل وجوب الاحتياط أيضا، إلا أن دلالتها موهونة من جهة أخرى.
وهي أن ظاهر الموصول العموم، فالتوبيخ على الالتزام بترك الشئ مع تفصيل جميع المحرمات الواقعية وعدم كون المتروك منها.
ولا ريب أن اللازم من ذلك العلم بعدم كون المتروك محرما واقعيا، فالتوبيخ في محله.
والانصاف: ما ذكرنا، من أن الايات المذكورة لا تنهض على إبطال القول بوجوب الاحتياط، لان غاية مدلول الدال منها هو عدم التكليف فيها لم يعلم خصوصا أو عموما بالعقل أو النقل.وهذا مما لا نزاع فيه لاحد.
وإنما أوجب الاحتياط من أوجبه بزعم قيام الدليل العقلي أو النقلي على وجوبه.
فاللازم على منكره رد ذلك الدليل أو معارضته بما يدل على الرخصة وعدم وجوب الاحتياط فيما لا نص فيه.
وأما الايات المذكورة، فهي كبعض الاخبار الاتية لا تنهض بذلك، ضرورة أنه إذا فرض أنه ورد بطريق معتبر في نفسه أنه يجب الاحتياط في كل ما يحتمل أن يكون قد حكم الشارع فيه بالحرمة لم يكن يعارضه شئ من الايات المذكورة.
وأما السنة فيذكر منها في المقام أخبار كثيرة منها: المروي عن النبي، صلى الله عليه وآله، بسند صحيح في الخصال، كما عن التوحيد: (رفع عن أمتي تسعة أشياء: الخطأ، والنسيان، وما أستكرهوا عليه وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما أضطروا إليه..)، الخبر.
فإن حرمة شرب التتن، مثلا، مما لا يعلمون، فهي مرفوعة عنهم، ومعنى رفعها، كرفع الخطأ والنسيان، رفع آثارها أو خصوص المؤاخذة.
فهو نظير قوله عليه السلام: (ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم).
ويمكن أن يورد عليه: بأن الظاهر من الموصول فيما لا يعلمون، بقرينة أخواتها، هو الموضوع، أعني فعل المكلف الغير المعلوم، كالفعل الذي لا يعلم أن شرب الخمر أو شرب الخل، وغير ذلك من الشبهات الموضوعية، فلا يشمل الحكم الغير المعلوم.
مع أن تقدير المؤاخذة في الرواية لا يلائم عموم الموصول للموضوع والحكم، لان المقدر المؤاخذة على نفس هذه المذكورات، ولا معنى للمؤاخذة على نفس الحرمة المجهولة.نعم هي من آثارها.
فلو جعل المقدر في كل من هذه التسعة ما هو المناسب من أثره، أمكن أن يقال: إن أثر حرمة شرب التتن المؤاخدة على فعله فهي مرفوعة، لكن الظاهر، بناء على تقدير المؤاخذة، نسبة المؤاخذة إلى نفس المذكورات.
والحاصل: أن المقدر في الرواية، بإعتبار دلالة الاقتضاء، يحتمل أن يكون جميع الاثار في كل واحد من التسعة، وهو الاقرب إعتبارا إلى المعنى الحقيقي، وأن يكون في كل منها ما هو الاثر الظاهر فيه، وأن يقدر المؤاخذة في الكل.
وهذا أقرب عرفا من الاول وأظهر من الثاني أيضا، لان الظاهر أن نسبة الرفع إلى مجموع التسعة على نسق واحد.
فإذا أريد، من الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما أضطروا، المؤاخذة على أنفسها، كان الظاهر فيما لا يعلمون ذلك أيضا.
نعم يظهر من بعض الاخبار الصحيحة عدم إختصاص المرفوع عن الامة بخصوص المؤاخذة.
فعن المحاسن عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، والبزنطي جميعا، عن أبي الحسن عليه السلام: (في الرجل يستحلف على اليمين فحلف بالطلاق والعتاق وصدقه ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال عليه السلام: لا.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه، وما لا يطيقون، وما أخطأوا، الخبر).
فإن الحلف بالطلاق والعتاق والصدقه وإن كان باطلا عندنا مع الاختيار أيضا، إلا أن إستشهاد الامام، عليه السلام، على عدم لزومها مع الاكراه على الحلف بها بحديث الوضع، شاهد على عدم إختصاصه بوضع خصوص المؤاخذة.
لكن النبوي المحكي في كلام الامام، عليه السلام، مختص بثلاثة من التسعة، فلعل نفي جميع الاثار مختص بها، فتأمل.
ومما يؤيد إرادة العموم ظهور كون رفع كل واحد من التسعة من خواص أمة النبي " ص "، إذ لو إختص الرفع بالمؤاخذة أشكل الامر في كثير من تلك الامور، من حيث أن العقل مستقل بقبح المؤاخذة عليها، فلا إختصاص له بأمة النبي " ص "، على ما يظهر من الرواية.
والقول بأن الاختصاص بإعتبار رفع المجموع وإن لم يكن رفع كل واحد من الخواص شطط من الكلام.
لكن الذي يهون الامر في الرواية جريان هذا الاشكال في الكتاب العزيز أيضا، فإن موارد الاشكال فيها، وهي الخطأ والنسيان وما لا يطاق ومنا أضطروا إليه، هي بعينها ما إستوهبها النبي " ص " من ربه، جل ذكره، ليلة المعراج، على ما حكاه الله تعالى عنه " ص " في القرآن بقوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، كما حملته على الذين من قبلنا).
والذي يحسم أصل الاشكال منع إستقلال العقل بقبح المؤاخذة على هذه الامور بقول مطلق، فإن الخطأ والنسيان الصادرين من ترك التحفظ لا يقبح المؤاخذة عليهما، وكذا المؤاخذة على ما لا
يعلمون من إمكان الاحتياط، وكذا التكليف الشاق الناشي عن إختيار المكلف.
والمراد بما لا يطاق في الرواية هو ما لا يتحمل في العادة، لا ما لا يقدر عليه أصلا، كالطيران في الهواء.
وأما في الاية فلا يبعد أن يراد به العذاب والعقوبة.
فمعنى (لا تحملنا ما لا طاقة لنا به): لا تورد علينا ما لا نطيقه من العقوبة.
وبالجملة فتأييد إرادة رفع جميع الاثار بلزوم الاشكال على تقدير الاختصاص برفع المؤاخذة ضعيف جدا.
وأضعف منه وهن إرادة العموم بلزوم كثرة الاضمار، وهو كما ترى، وإن ذكره بعض الفحول.
ولعله أراد بذلك أن المتيقن رفع المؤاخذة، ورفع ما عداه يحتاج إلى دليل.
وفيه: أنه إنما يحسن الرجوع إليه بعد الاعتراف بإجمال الرواية، لا لاثبات ظهورها في رفع المؤاخذة، إلا ان يراد إثبات ظهورها، من حيث أن حملها على خصوص المؤاخذة يوجب عدم التخصيص في عموم الادلة المثبتة لآثار تلك الامور وحملها على العموم يوجب التخصيص فيها.
فعموم تلك الادلة مبين لتلك الرواية، فإن المخصص إذا كان مجملا من جهة تردده بين ما يوجب كثرة الخارج وبين ما يوجب قلته، كان عموم العام بالنسبة إلى التخصيص المشكوك فيه مبينا لاجماله، فتأمل وأجمل.
وأضعف من الوهن المذكور وهن العموم بلزوم التخصيص بكثير من الآثار بل أكثرها، حيث أنها لا ترتفع بالخطأ والنسيان وأخواتهما.وهو ناش عن عدم تحصيل معنى الرواية كما هو حقه.
فاعلم أنه إذا بنينا على عموم رفع الاثار، فليس المراد بها الاثار المترتبة على هذه العنوانات من حيث هي، إذ لا يعقل رفع الاثار الشرعية المترتبة على الخطأ، والسهو من حيث هذين العنوانين، كوجوب الكفارة المترتب على قتل الخطأ، ووجوب سجدتي السهو المترتب على نسيان بعض الاجزاء، وليس المراد أيضا رفع الآثار المترتبة على الشئ بوصف عدم الخطاء.
مثل قوله: (من تعمد الافطار فعليه كذا)، لان هذا الاثر يرتفع بنفسه في صورة الخطأ.
بل المراد أن الآثار المترتبة على نفس الفعل لا بشرط الخطأ والعمد قد رفعها الشارع عن ذلك الفعل إذا صدر عن خطاء.
ثم المراد بالآثار هي الآثار المجعولة الشرعية التي وضعها الشارع، لانها هي القابلة للارتفاع برفعه.
وأما ما لم يكن يجعله من الاثار العقلية والعادية، فلا تدل الرواية على رفعها ولا رفع الآثار المجعولة المترتبة عليها.
ثم المراد بالرفع ما يشمل عدم التكليف مع قيام المقتضي له، فيعم الدفع ولو بأن يوجه
التكليف على وجه يختص بالعامد، وسيجئ بيانه.
فإن قلت: على ما ذكرت يخرج أثر التكليف فيما لا يعلمون عن مورد الرواية، لان إستحقاق العقاب أثر عقلي له مع أنه متفرع على المخالفة بقيد العمد، إذ مناطه، أعنى المعصية، لا يتحقق إلا بذلك.
وأما نفس المؤاخذة فليست من الآثار المجعولة الشرعية.
والحاصل أنه ليس فيما لا يعلمون أثر مجعول من الشارع مترتب على الفعل لا بقيد العلم والجهل حتى يحكم الشارع بإرتفاعه مع الجهل.
قلت: قد عرفت أن المراد برفع التكليف عدم توجيهه إلى المكلف مع قيام المقتضي له، سواء كان هناك دليل يثبته لولا الرفع أم لا.فالرفع هنا نظير رفع الحرج في الشريعة.
وحينئذ فإذا فرضنا أنه لا يقبح في العقل أو يوجد التكليف بشرب الخمر على وجه يشمل صورة الشك فيه، فلم يفعل ذلك، ولم يوجب تحصيل العلم ولو بالاحتياط ووجه التكليف على وجه يختص بالعالم تسهيلا على المكلف كفى في صدق الرفع.
وهكذا الكلام في الخطأ والنسيان، فلا يشترط في تحقق الرفع وجود دليل يثبت التكليف في حال العمد وغيره.
نعم لو قبح عقلا المؤاخذه على الترك.
كما في الغافل الغير المتمكن من الاحتياط، لم يكن في حقه رفع أصلا، إذ ليس من شأنه أن يوجه إليه التكليف.
وحينئذ فنقول: معنى رفع أثر التحريم فيما لا يعلمون عدم إيجاب الاحتياط والتحفظ فيه حتى يلزمه ترتب العقاب، إذا أفضى ترك التحفظ إلى الوقوع على الحرام الواقعي.وكذلك الكلام في رفع أثر النسيان والخطأ، فإن مرجعه إلى عدم إيجاب التحفظ عليه.وإلا فليس في التكاليف ما يعم صورة النسيان لقبح تكليف الغافل.
والحاصل: أن المرتفع، في ما لا يعلمون وأشبهاهه مما لا يشمله أدلة التكليف، هو إيجاب التحفظ على وجه لا يقع في مخالفة الحرام الواقعي، ويلزمه إرتفاع العقاب وإستحقاقه.فالمرتفع أول وبالذات أمر مجعول يترتب عليه إرتفاع أمر غير مجعول.
ونظير ذلك ما ربما يقال في رد من تمسك، على عدم وجوب الاعادة على من صلى في النجاسة ناسيا، بعموم حديث الرفع من: (أن وجوب الاعادة وإن كان حكما شرعيا إلا أنه مترتب على مخالفة المأتي به للمأمور به الموجب لبقاء الامر الاول، وهي ليست من الاثار الشرعية للنسيان، وقد تقدم أن الرواية لا تدل على رفع الاثار الغير الجعولة ولا الاثار الشرعية المترتبة عليها، كوجوب الاعادة فيما نحن فيه).
ويرده: ما تقدم في نظيره، من أن الرفع راجع هنا إلى شرطية طهارة اللباس بالنسبة إلى
الناسي، فيقال بحكم حديث الرفع: إن شرطية الطهارة شرعا مختصة بحال الذكر، فيصير صلاة الناسي في النجاسة مطابقة للمأمور به فلا يجب الاعادة.وكذلك الكلام في الجزء المنسي، فتأمل.
واعلم أيضا أنه لو حكمنا بعموم الرفع لجميع الآثار فلا يبعد إختصاصه بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان على الامة، كما إذا إستلزم إضرار المسلم.فإتلاف المال المحترم نسيانا أو خطأ لا يرتفع معه الضمان.
وكذلك الاضرار بمسلم، لدفع الضرر عن نفسه، لا يدخل في عموم ما أضطروا إليه، إذ لا إمتنان في رفع الاثر عن الفاعل بإضرار الغير، فليس الاضرار بالغير نظير سائر المحرمات الالهية المسوغة لدفع الضرر.
وأما ورود الصحيحة المتقدمة عن المحاسن في مورد حق الناس، أعني العتق والصدقة، فرفع أثر الاكراه عن الحالف يوجب فوات نفع على المعتق والفقراء، لا إضرارا بهم.
وكذلك رفع أثر الاكراه عن المكره، فيما إذا تعلق بإضرار مسلم من باب عدم وجوب تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغير، لا ينافي الامتنان، وليس من باب الاضرار على الغير لدفع الضرر عن النفس لينافي ترخيصه الامتنان على العباد، فإن الضرر أولا وبالذات متوجه على الغير بمقتضى إرادة المكرة بالكسر، لا على المكره بالفتح، فافهم.
بقي في المقام شئ وإن لم يكن مربوطا به وهو أن النبوي المذكور مشتمل على ذكر الطيرة والحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفتيه، وظاهره رفع المؤاخذة على الحسد مع مخالفته لظاهر الاخبار الكثيرة.
ويمكن حمله على ما لم يظهر الحاسد أثره باللسان أو غيره بجعل عدم النطق باللسان قيدا له أيضا.
ويؤيده تأخير الحسد عن الكل في مرفوعة النهدي عن أبي عبدالله، عليه السلام، المروية في أواخر أبواب الكفر والايمان من أصول الكافي: (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي تسعة أشياء: الخطأ، والنسيان، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما أضطروا إليه، وما أستكرهوا عليه والطيرة والوسوسة في التفكر في الخلق، والحسد ما لم يظهر بلسان أو بيد)، الحديث.
ولعل الاقتصار في النبوي الاول على قوله (ما لم ينطق)، لكونه أدنى مراتب الاظهار.
وروي: (ثلاثة لا يسلم منها أحد، الطيرة والحسد والظن.
قيل: فما نصنع؟ قال: إذا تطيرت
فامض، وإذا حسدت فلا تبغ، وإذا ظننت فلا تحقق).
والبغي عبارة عن إستعمال الحسد، وسيأتى في رواية الخصال: (إن المؤمن لا يستعمل حسده).
ولاجل ذلك عد في الدروس من الكبائر في باب الشهادات إظهار الحسد، لا نفسه، وفي الشرايع: (إن الحسد معصية، وكذا الظن بالمؤمن، والتظاهر بذلك قادح في العدالة).
والانصاف: أن في كثير من أخبار الحسد إشاره إلى ذلك.
وأما الطيرة، بفتح الياء، وقد يسكن، وهي في الاصل التشأم بالطير، لان أكثر تشأم العرب كان به، خصوصا الغراب.
والمراد إما رفع المؤاخذة عليها، ويؤيده ما روي من أن الطيرة شرك وإنما يذهبه التوكل، وإما رفع أثرها، لان الطيرة كان يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع.
وأما الوسوسة في التفكر في الخلق، كما في النبوي الثاني، أو التفكر في الوسوسة فيه، كما في الاول، فهما واحد.
والاول أنسب، ولعل الثاني إشتباه من الراوي.
والمراد به - كما قيل -: وسوسة الشيطان للانسان عند تفكره في أمر الخلقة.
وقد إستفاضت الاخبار بالعفو عنه.
ففي صحيحة جميل بن دراج قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إنه يقع في قلبي أمر عظيم، فقال عليه السلام: قل: لا إله إلا الله.
قال جميل: فكلما وقع في قلبي شئ قلت لا إله إلا الله فذهب عني).
وفي رواية حمران عن أبي عبدالله، عليه السلام، عن الوسوسة وإن كثرت.
قال عليه السلام: (لا شئ فيها، تقول: لا إله إلا الله).
وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام: (جاء رجل إلى النبي، صلى الله عليه وآله، فقال: يا رسول الله ! إني هلكت.
فقال " ص " له: أتاك الخبيث، فقال لك: من خلقك.
فقلت: الله تعالى.
فقال: الله من خلقه؟ فقال: إي والذي بعثك بالحق، قال كذا.
فقال " ص ": ذاك والله محض الايمان).
قال إبن أبي عمير، حدثت ذلك عبدالرحمن بن حجاج، فقال: حدثني أبي عن أبي عبدالله عليه السلام: (إن رسول الله، صلى الله عليه وآله، إنما عني بقوله (هذا محض الايمان) خوفه أن يكون قد هلك حيث عرض في قلبه ذلك)
وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وآله: (والذي بعثني بالحق إن هذا لصريح الايمان.
فإذا وجدتموه فقولوا: آمنا بالله ورسوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله).
وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وآله: (إن الشيطان أتاكم من قبل الاعمال، فلم يقو عليكم، فأتاكم من هذا الوجه لكي يستزلكم، فإذا كان كذلك فليذكر أحدكم الله تعالى وحده).
ويحتمل أن يراد بالوسوسة في الخلق الوسوسة في أمور الناس وسوء الظن بهم.
وهذا أنسب بقوله: (ما لم ينطق بشفتيه).
ثم هذا الذي ذكرنا، هو الظاهر المعروف في معنى الثلاثة الاخيرة المذكورة في الصحيحة.
وفي الخصال، بسند فيه رفع، عن أبي عبدالله عليه السلام: (قال ثلاث لم يعر منها نبي فمن دونه، الطيرة والحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق).
وذكر الصدوق، رحمه الله، في تفسيرها: أن المراد بالطيرة التطير بالنبي " ص " إذ المؤمن لا يطيره.
كما حكى الله، عزوجل، عن الكفار: (قالوا اطيرنا بك وبمن معك).
والمراد بالحسد أن يحسد، لا أن يحسد، كما قال الله تعالى: (أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله).
والمراد بالتفكر إبتلاء الانبياء، عليهم السلام، بأهل الوسوسة، لا غير ذلك، كما حكى الله عن الوليد بن مغيرة: (إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر).فافهم.
وقد خرجنا في الكلام في النبوي الشريف عما يقتضيه وضع الرسالة.
ومنها: قوله، عليه السلام: (ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم).
فإن المحجوب حرمة شرب التتن، فهي موضوعة عن العباد.
وفيه: أن الظاهر مما حجب الله تعالى علمه ما لم يبينه للعباد، لا ما بينه واختفى [ عليهم ] من معصية من عصى الله في كتمان الحق أو ستره فالرواية مساوقة لما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: (إن الله تعالى حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تعصوها، وسكت عن أشياء، لم يسكت عنها نسيانا لها، فلا تتكلفوها، رحمة من الله لكم).
ومنها: قوله عليه السلام: (الناس في سعة مما لم يعلموا).
فإن كلمة (ما) إما موصولة أضيف إليه السعة وإما مصدرية ظرفية، وعلى التقديرين يثبت المطلوب.
وفيه: ما تقدم في الايات من أن الاخباريين لا ينكرون عدم وجوب الاحتياط على من لم يعلم بوجوب الاحتياط من العقل والنقل بعد التأمل والتتبع.
ومنها: رواية عبدالاعلى عن الصادق عليه السلام: (قال: سألته عمن لم يعرف شيئا، هل عليه شئ؟ قال: لا).
بناء على أن المراد بالشئ الاول فرد معين مفروض في الخارج حتى لا يفيد العموم في النفي، فيكون المراد: هل عليه شئ في خصوص ذلك الشئ المجهول.
وأما بناء على إرادة العموم، فظاهره السؤال عن القاصر الذي لا يدرك شيئا.
ومنها: قوله صلى الله عليه وآله: (أيما إمرء إرتكب أمرا بجهالة فلا شئ عليه).
وفيه: أن الظاهر من الرواية ونظائرها من قولك: (فلان عمل هكذا بجهالة)، هو إعتقاد الصواب أو الغفلة عن الواقع، فلا يعم صورة التردد في كون فعله صوابا أو خطأ.
ويؤيده أن تعميم الجهالة بصورة التردد يحوج الكلام إلى التخصيص بالشاك الغير المقصر، وسياقه يأبى عن التخصيص، فتأمل.
ومنها: قوله عليه السلام: (إن الله تعالى يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم).
وفيه: أن مدلوله، كما عرفت في الايات وغير واحد من الاخبار، مما لا ينكره الاخباريون.
ومنها: قوله عليه السلام في مرسلة الفقيه: (كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي).
إستدل به الصدوق على جواز القنوت بالفارسية وإستند إليه في أماليه حيث جعل إباحة الاشياء حتى يثبت الحظر من دين الامامية.ودلالته على المطلب أوضح من الكل.
وظاهره عدم وجوب الاحتياط، لان الظاهر إرادة ورود النهي في الشئ من حيث هو، لا من حيث كونه مجهول الحكم.
فإن تم ما سيأتي من أدلة الاحتياط دلالة وسندا وجب ملاحظة التعارض بينها وبين هذه الرواية وأمثالها مما يدل على عدم وجوب الاحتياط، ثم الرجوع إلى ما يقتضيه قاعدة التعارض.
وقد يحتج بصحيحة عبدالرحمن بن حجاج: (فيمن تزوج إمرأة في عدتها، قال: أما إذا كان
بجهالة فليتزوجها بعدما ينقضي عدتها، فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك.
قلت: بأي الجهالتين أعذر، أبجهالته أن ذلك محرم عليه، أم بجهالته أنها في عدة؟ قال: إحدى الجهالتين أهون من الاخرى.الجهالة بأن الله تعالى حرم عليه ذلك.وذلك لانه لا يقدر معها على الاحتياط.
قلت: فهو في الاخرى معذور.
قال عليه السلام: نعم، إذا إنقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها).
وفيه: أن الجهل بكونها في العدة إن كان مع العلم بالعدة في الجملة والشك في إنقضائها، فإن كان الشك في أصل الانقضاء مع العلم بمقدارها فهو شبهة في الموضوع خارج عما نحن فيه، مع أن مقتضى الاستصحاب المركوز في الاذهان عدم الجواز.
ومنه يعلم أنه لو كان الشك في مقدار العدة فهي شبهة حكمية قصر في السؤال عنها، وليس معذورا فيها إتفاقا، لاصالة بقاء العدة وأحكامها، بل في رواية أخرى أنه: (إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة).
فالمراد من المعذورية عدم حرمتها عليه مؤبدا لا من حيث المؤاخذة.
ويشهد له أيضا قوله عليه السلام - بعد قوله: (نعم إذا إنقضت عدتها) -: (جاز له أن يتزوجها).
وكذا مع الجهل بأصل العدة، لوجوب الفحص وأصالة عدم تأثير العقد، خصوصا مع وضوح الحكم بين المسلمين الكاشف عن تقصير الجاهل.
هذا إن كان الجاهل ملتفتا شاكا، وإن كان غافلا أو معتقدا للجواز فهو خارج عن مسألة البراءة، لعدم قدرته على الاحتياط.
وعلى يحمل تعليل معذورية الجاهل بالتحريم بقوله عليه السلام: (لانه لا يقدر، إلخ).
وإن كان تخصيص الجاهل بالحرمة بهذا التعليل يدل على قدرة الجاهل بالعدة على الاحتياط، فلا يجوز حمله على الغافل، إلا أنه إشكال يرد على الروايه على كل تقدير.ومحصله لزوم التفكيك بين الجهالتين، فتدبر فيه وفي دفعه.
وقد يستدل على المطلب، أخذا من الشهيد في الذكرى، بقوله عليه السلام: (كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه).
وتقريب الاستدلال، كما في شرح الوافية: (أن معنى الحديث أن كل فعل من جملة الافعال التي تتصف بالحل والحرمة، وكذا كل عين مما يتعلق به فعل المكلف ويتصف بالحل والحرمه إذا لم يعلم الحكم الخاص به من الحل والحرمة فهو حلال.
فخرج ما لا يتصف بهما جميعا من الافعال الاضطرارية والاعيان التي لا يتعلق بها فعل المكلف وما علم أنه حلال لا حرام فيه أو حرام لا حلال فيه.وليس الغرض من ذكر الوصف مجرد الاحتراز، بل هو مع بيان ما فيه الاشتباه.
فصار الحاصل: أن ما اشتبه حكمه وكان محتملا لان يكون حلالا ولان يكون حراما فهو حلال، سواء علم حكم كلي فوقه أو تحته بحيث لو فرض العلم بإندراجه تحته أو تحققه في ضمنه لعلم حكمه أم لا.
وبعبارة أخرى: إن كل شئ فيه الحلال والحرام عندك، بمعنى أنك تقسمه إلى هذين وتحكم عليه بأحدهما لا على التعيين ولا تدري المعين منهما، فهو لك حلال.
فيقال حينئذ: إن الرواية صادقة على مثل اللحم المشترى من السوق المحتمل للمذكى والميتة، وعلى شرب التتن، وعلى لحم الحمير، إن لم نقل بوضوحه وشككنا فيه، لانه يصدق على كل منها أن شئ فيه حلال وحرام عندنا، بمعنى أنه يجوز لنا أن نجعله مقسما لحكمين فنقول: هو إما حلال وإما حرام، وإنه يكون من جملة الافعال التي يكون بعض أنواعها أو أصنافها حلالا وبعضها حراما واشتركت في أن الحكم الشرعي المتعلق بها غير معلوم) إنتهى.
أقول: الظاهر أن المراد بالشئ ليس هو خصوص المشتبه، كاللحم المشترى ولحم الحمير على ما مثله بهما، إذ لا يستقيم إرجاع الضمير في (منه) إليهما، لكن لفظة (منه) ليس في بعض النسخ.
وايضا: الظاهر أن المراد بقوله عليه السلام: (فيه حلال وحرام) كونه منقسما إليهما ووجود القسمين فيه بالفعل لا مرددا بينهما، إذ لا تقسيم مع الترديد أصلا، لا ذهنا ولا خارجا.
وكون الشئ مقسما لحكمين، كما ذكره المستدل، لم يعلم له معنى محصل.
خصوصا مع قوله قدس الله سره (أنه يجوز لنا ذلك)، لان التقسيم إلى الحكمين، الذي هو في الحقيقة ترديد لا تقسيم، أمر لازمي قهري لا جائز لنا.
وعلى ما ذكرنا فالمعنى - والله العالم - أن كل كلي فيه قسم حلال وقسم حرام، كمطلق لحم الغنم المشترك بين المذكى والميتة، فهذا الكلي لك حلال إلى أن تعرف القسم الحرام معينا في
الخارج فتدعه.
وعلى الاستخدام يكون المراد: أن كل جزئي خارجي في نوعه القسمان المذكوران فذلك الجزئي لك حلال حتى تعرف القسم الحرام من ذلك الكلي في الخارج فتدعه.
وعلى أي تقدير: فالرواية مختصة بالشبهة في الموضوع.
وأما ما ذكره المستدل - من أن المراد من وجود الحلال والحرام فيه إحتماله وصلاحيته لهما - فهو مخالف لظاهر القضية ولضمير (منه) ولو على الاستخدام.
ثم الظاهر: أن ذكر هذا القيد مع تمام الكلام بدونه - كما في قوله عليه السلام في رواية أخرى: (كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام) بيان منشأ الاشتباه الذي يعلم من قوله عليه السلام: (حتى تعرف).
كما أن الاحتراز عن المذكورات في كلام المستدل ايضا يحصل بذلك.
ومنه يظهر فساد ما انتصر بعض المعاصرين للمستدل، بعد الاعتراف بما ذكرنا من ظهور القضيه في الانقسام الفعلي، فلا يشمل مثل شرب التتن: من: (أنا نفرض شيئا له قسمان حلال وحرام واشتبه قسم ثالث منه، كاللحم، فإنه شئ فيه حلال وهو لحم الغنم وحرام وهو لحم الخنزير.
فهذا الكلي المنقسم حلال، فيكون لحم الحمار حلالا حتى نعرف حرمته) ووجه الفساد: أن وجود القسمين في اللحم ليس منشاء لاشتباه لحم الحمار ولا دخل له في هذا الحكم أصلا، ولا في تحقق الموضوع، وتقييد الموضوع بقيد أجنبي لا دخل له في الحكم ولا في تحقق الموضوع مع خروج بعض الافراد منه، مثل شرب التتن.
حتى احتاج هذا المنتصر إلى إلحاق مثله بلحم الحمار وشبهه مما يوجد في نوعه قسمان معلومان بالاجماع المركب مستهجن جدا لا ينبغي صدوره من متكلم فضل عن الامام عليه السلام.
هذا، مع أن اللازم مما ذكر عدم الحاجه إلى الاجماع المركب، فإن الشرب فيه قسمان شرب الماء وشرب البنج وشرب التتن كلحم الحمار بعينه.وهكذا جميع الافعال المجهولة الحكم.
وأما الفرق بين الشرب واللحم بأن الشرب جنس بعيد لشرب التتن بخلاف اللحم، فمما لا ينبغي أن يصغى إليه.
هذا كله، مضافا إلى أن الظاهر من قوله: (حتى تعرف الحرام منه)، معرفة ذلك الحرام الذي
فرض وجوده في الشئ، ومعلوم أن معرفة لحم الخنزير وحرمته لا يكون غاية لحلية لحم الحمار.
وقد اورد على الاستدلال: (بلزوم إستعمال قوله عليه السلام: (فيه حلال و حرام)، في معنيين، أحدهما أنه قابل للاتصاف بهما.
وبعبارة أخرى: يمكن تعلق الحكم الشرعي به ليخرج ما لا يقبل الاتصاف بشئ منهما.
والثاني أنه منقسم إليهما ويوجد النوعان فيه إما في نفس الامر أو عندنا، وهو غير جائز، وبلزوم إستعمال قوله عليه السلام: (حتى تعرف الحرام منه بعينه)، في المعنيين أيضا، لان المراد حتى تعرف من الادلة الشرعية الحرمة إذا أريد معرفة الحكم المشتبه، وحتى تعرف من الخارج من بينة أو غيرها الحرمة إذا أريد معرفة الموضوع المشتبه فليتأمل)، إنتهى.وليته أمر بالتأمل في الايراد الاول أيضا.ويمكن إرجاعه إليهما معا، وهو الاولى.وهذه جملة ما إستدل به من الاخبار.
والانصاف: ظهور بعضها في الدلالة على عدم وجوب الاحتياط فيما لا نص فيه في الشبهة بحيث لو فرض تمامية الاخبار الاتية للاحتياط وقعت المعارضة بينها.
لكن بعضها غير دال إلا على عدم وجوب الاحتياط لو لم يرد أمر عام به، فلا يعارض ما سيجئ من أخبار الاحتياط لو نهضت للحجية سندا ودلالة.
وأما الاجماع فتقريره من وجهين.
الاول: دعوى إجماع العلماء كلهم من المجتهدين والاخباريين على أن الحكم - فيما لم يرد فيه دليل عقلي أو نقلي على تحريمه من حيث هو، ولا على تحريمه من حيث أنه مجهول الحكم هي البراءة و عدم العقاب على الفعل.
وهذا الوجه لا ينفع إلا بعد عدم تمامية ما ذكر من الدليل العقلي والنقلي للحظر والاحتياط.
فهو نظير حكم العقل الاتي.
الثاني: دعوى الاجماع على أن الحكم - فيما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو - هو عدم وجوب الاحتياط وجواز الارتكاب.
وتحصيل الاجماع بهذا النحو من وجوه: الاول: ملاحظة فتاوى العلماء في موارد الفقه فإنك لا تكاد تجد من زمان المحدثين إلى زمان ارباب التصنيف في الفتوى من يعتمد على حرمة شئ من الافعال بمجرد الاحتياط.
نعم ربما يذكرونه في طي الاستدلال في جميع الموارد، حتى في الشبهة الوجوبية التي إعترف القائلون بالاحتياط بعدم وجوبه فيها.ولا بأس بالاشاره إلى من وجدنا في كلماتهم ما هو ظاهر في هذا القول.
فمنهم ثقة الاسلام الكليني، رحمه الله، حيث صرح في ديباجة الكافي ب (أن الحكم فيما اختلف فيه الاخبار التخيير).
ولم يلزم الاحتياط مع ورود الاخبار بوجوب الاحتياط فيما تعارض فيه النصان.
وما لم يرد فيه نص بوجوبه في خصوص ما لا نص فيه فالظاهر أن كل من قال بعدم وجوب الاحتياط هناك قال به هنا.
ومنهم الصدوق، رحمه الله، فإنه قال: (اعتقادنا أن الاشياء على الاباحة حتى يرد النهي).
ويظهر من هذا موافقة والده ومشايخه، لانه لا يعبر بمثل هذه العبارة مع مخالفته لهم، بل ربما يقول: (الذي أعتقده وأفتي به)، واستظهر من عبارته هذه أنه من دين الامامية.
وأما السيدان، فقد صرحا بإستقلال العقل بإباحة ما لا طريق إلى كونه مفسدة وصرحا أيضا في مسألة العمل بخبر الواحد أنه متى فرضنا عدم الدليل على حكم الواقعة رجعنا فيها إلى حكم العقل.
وأما الشيخ، قدس سره، فإنه وإن ذهب وفاقا لشيخه المفيد، رحمه الله، إلى أن الاصل في الاشياء من طريق العقل الوقف، إلا أنه صرح في العدة ب (أن حكم الاشياء من طريق العقل وإن كان هو الوقف لكنه لا يمتنع أن يدل دليل سمعي على أن الاشياء على الاباحة بعد أن كانت على الوقف، بل عندنا الامر كذلك وإليه نذهب)، إنتهى.
وأما من تأخر عن الشيخ، رحمه الله، كالحلبي والعلامة والمحقق والشهيدين وغيرهم، فحكمهم بالبراءة يعلم من مراجعة كتبهم.
وبالجملة فلا نعرف قائلا معروفا بالاحتياط وإن كان ظاهر المعارج نسبته إلى جماعة.
ثم إنه ربما نسب إلى المحقق، قدس سره، رجوعه عما في المعارج إلى ما في المعتبر من التفصيل بين ما يعم به البلوى وغيره وأنه لا يقول بالبراءة في الثاني.وسيجئ الكلام في هذه النسبة بعد ذكر الادلة إن شاء الله.
ومما ذكرنا يظهر أن تخصيص بعض القول بالبراءة بمتأخري الامامية مخالف للواقع، وكأنه ناش عما رأي من السيد، رحمه الله، والشيخ، رحمه الله، من التمسك بالاحتياط في كثير من الموارد.
ويؤيده ما في المعارج من نسبة القول برفع الاحتياط على الاطلاق إلى جماعة.
الثاني: الاجماعات المنقولة والشهرة المحققة فإنها قد تفيد القطع بالاتفاق.
وممن استظهر منه دعوى ذلك الصدوق، رحمه الله، في عبارته المتقدمة عن إعتقاداته.
وممن إدعى إتفاق المحصلين عليه الحلي في أول السرائر حيث قال، بعد ذكر الكتاب والسنة والاجماع: (إنه إذا فقدت الثلاثة، بالمعتمد في المسألة الشرعية عند المحققين الباحثين عن مأخذ الشريعة التمسك بدليل العقل) إنتهى.
ومراده بدليل العقل، كما يظهر من تتبع كتابه، هو أصل البراءة.
وممن إدعى إطباق العلماء المحقق في المعارج في باب الاستصحاب، وعنه في المسائل المصرية أيضا في توجيه نسبة السيد إلى مذهبنا جواز إزالة النجاسة بالمضاف مع عدم ورود نص فيه: (إن من أصلنا العمل بالاصل، حتى يثبت بالناقل ولم يثبت المنع عن إزالة النجاسة بالمايعات).
فولا كون الاصل إجماعيا لم يحسن من المحقق، قدس سره، جعله وجها لنسبة مقتضاه إلى مذهبنا.
وأما الشهرة فإنما تتحقق بعد التتبع في كلمات الاصحاب خصوصا في الكتب الفقهية.
ويكفي في تحققها ذهاب من ذكرنا من القدماء والمتأخرين.
الثالث: الاجماع العملي الكاشف عن رضاء المعصوم فإن سيرة المسلمين من أول الشريعة بل في كل شريعة على عدم الالتزام والالزام بترك ما يحتمخل ورود النهي عنه من الشارع بعد الفحص وعدم الوجدان، وأن طريقة الشارع كان تبليغ المحرمات دون المباحات وليس ذلك إلا لعدم إحتياج الرخصة في الفعل إلى البيان وكفاية عدم النهي فيه.
قال المحقق، رحمه الله، على ما حكي عنه: (إن الشرائع كافة لا يخطئون من بادر إلى تناول شئ من المشتهيات، سواء علم الاذن فيها من الشرع أم لم يعلم.
ولا يوجبون عليه عند تناول شئ من المأكول والمشروب أن يعلم التنصيص على إباحته، ويعذرونه في كثير من المحرمات إذا تناولها من غير علم.ولو كانت محظورة لاسرعوا إلى تخطئته حتى يعلم الاذن)، إنتهى.
أقول: إن كان الغرض مما ذكر من عدم التخطئة بيان قبح مؤاخذة الجاهل بالتحريم، فهو حسن مع عدم بلوغ وجوب الاحتياط عليه من الشارع، لكنه راجع إلى الدليل العقلي الاتي، ولا ينبغي الاستشهاد له بخصوص أهل الشرائع، بل بناء كافة العقلاء وإن لم يكونوا من أهل الشرائع على قبح ذلك.
وإن كان الغرض منه أن بناء العقلاء على تجويز الارتكاب مع قطع النظر عن ملاحظة قبح مؤاخذة الجاهل، حتى لو فرض عدم قبحه لفرض العقاب من اللوازم القهرية لفعل الحرام مثلا أو فرض المولى في التكاليف العرفية ممن يؤاخذ على الحرام ولو صدر جهلا لم يزل بناؤهم على ذلك، فهو مبني على عدم وجوب دفع الضرر المحتمل، وسيجئ الكلام فيه إن شاء الله.
الرابع من الادلة حكم العقل بقبح العقاب على شئ من دون بيان التكليف.
ويشهد له حكم العقلاء كافة بقبح مؤاخذة المولى عبده على فعل ما يعترف بعدم إعلامه أصلا بتحريمه.
ودعوى: (أن حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بيان عقلي، فلا يقبح بعده المؤاخذة)، مدفوعة: بأن الحكم المذكور على تقدير ثبوته لا يكون بيانا للتكليف المجهول المعاقب عليه.
وإنما هو بيان لقاعدة كلية ظاهرية وإن لم يكن في مورده تكليف في الواقع، لو تمت عوقب على مخالفتها وإن لم يكن تكليف في الواقع، لا على التكليف المحتمل على فرض وجوده فلا تصلح القاعدة لورودها على قاعدة القبح المذكوره، بل قاعدة القبح واردة عليها، لانها فرع إحتمال الضرر، أعني العقاب، ولا إحتمال بعد حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان.
فمورد قاعدة دفع العقاب المحتمل هو ما ثبت العقاب فيه ببيان الشارع للتكليف فتردد المكلف به بين أمرين، كما في الشبهة المحصورة وما يشبهها.هذا كله إن أريد بالضرر العقاب.
وإن أريد مضرة أخرى غير العقاب التي لا يتوقف ترتبها على العلم، فهو وإن كان محتملا لا يرتفع إحتماله بقبح العقاب من غير بيان، إلا أن الشبهة من هذه الجهة موضوعية لا يجب الاحتياط فيها بإعتراف الاخباريين.
فلو ثبت وجوب دفع المضرة المحتملة لكان هذا مشترك الورود.
فلا بد على كلا القولين إما من منع وجوب الدفع وإما من دعوى ترخيص الشارع وإذنه فيما شك في كونه من مصاديق الضرر.وسيجئ توضيحه في الشبهة الموضوعية إن شاء الله تعالى.
ثم إنه ذكر السيد أبوالمكارم، قدس سره، في الغنية: (أن التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق).
وتبعه بعض من تأخر عنه فاستدل به في مسألة البراءة.
والظاهر أن المراد به ما لا يطاق الامتثال به وإتيانه بقصد الطاعة.
كما صرح به جماعة من الخاصة والعامة في دليل إشتراط
التكليف بالعلم، وإلا فنفس الفعل لا يصير مما لا يطاق بمجرد عدم العلم بالتكليف به.
واحتمال: (كون الغرض من التكليف مطلق صدور الفعل ولو مع عدم قصد الاطاعة، أو يكون الغرض من التكليف مع الشك فيه إتيان الفعل لداعي حصول الانقياد بقصد الاتيان بمجرد إحتمال كونه مطلوبا للامر.
وهذا ممكن من الشاك وإن لم يكن من الغافل)، مدفوع، بأنه إن قام دليل على وجوب إتيان الشاك في التكليف بالفعل لاحتمال المطلوبية، أغنى ذلك عن التكليف بنفس الفعل وإلا لم ينفع التكليف المشكوك في تحصيل الغرض المذكور.
والحاصل: أن التكليف المجهول لا يصح، لكون الغرض منه الحمل على الفعل مطلقا، وصدور الفعل من الفاعل أحيانا لا لداعي التكليف لا يمكن أن يكون غرضا للتكليف.
واعلم: أن هذا الدليل العقلي، كبعض ما تقدم من الادلة النقلية، معلق على عدم تمامية أدلة الاحتياط فلا يثبت به إلا الاصل في مسألة البراءة ولا يعد من أدلتها بحيث يعارض أخبار الاحتياط.
وقد يستدل على البراءة بوجوه غير ناهضة منها: إستصحاب البراءة المتيقنة حال الصغر والجنون.
وفيه، أن الاستدلال به مبني على إعتبار الاستصحاب من باب الظن فيدخل أصل البراءة بذلك في الامارات الدالة على الحكم الواقعي دون الاصول المثبتة للاحكام الظاهرية.
وسيجئ عدم إعتبار الاستصحاب من باب الظن إن شاء الله.
وأما لو قلنا بإعتباره من باب الاخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك، فلا ينفع في المقام، لان الثابت بها ترتب اللوازم المجعولة الشرعية على المستصحب، والمستصحب هنا ليس إلا براءة الذمة من التكليف وعدم المنع من الفعل وعدم إستحقاق العقاب عليه.
والمطلوب في الان اللاحق هو القطع بعدم ترتب العقاب على الفعل أو ما يستلزم ذلك، إذ لو لم يقطع بالعدم واحتمل العقاب احتاج إلى إنضمام حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان إليه، حتى يأمن العقل عن العقاب، و معه لا حاجة إلى الاستصحاب وملاحظة الحالة السابقة.
ومن المعلوم أن المطلوب المذكور لا يترتب على المستصحبات المذكورة، لان عدم إستحقاق العقاب في الاخرة ليس من اللوازم المجعولة حتى يحكم به الشارع في الظاهر.
وأما الاذن والترخيص في الفعل، فهو وإن كان أمرا قابلا للجعل ويستلزم إنتفاء العقاب واقعا إلا أن الاذن الشرعي ليس لازما شرعيا للمستصحبات المذكورة، بل هو من المقارنات، حيث أن عدم المنع عن الفعل، بعد العلم إجمالا بعدم خلو فعل المكلف عن أحد الاحكام الخمسة، لا ينفك عن كونه مرخصا فيه.
فهو نظير إثبات وجود أحد الضدين بنفي الاخر بأصالة العدم.
ومن هنا تبين: أن إستدلال بعض من اعترف: بما ذكرنا - من عدم إعتبار الاستصحاب من باب الظن وعدم إثباته إلا اللوازم الشرعية في هذا المقام بإستصحاب البراءة - منظور فيه.
نعم من قال بإعتباره من باب الظن أو أنه يثبت بالاستصحاب من باب التعبد كل ما لا ينفك عن المستصحب لو كان معلوم البقاء ولو لم يكن من اللوازم الشرعية، فلا بأس بتمسكه به، مع أنه يمكن النظر فيه، بناء على ما سيجئ من إشتراط العلم ببقاء الموضوع في الاستصحاب.
وموضوع البراءة في السابق ومناطها هو الصغير الغير القابل للتكليف، فإنسحابها في القابل أشبه بالقياس من الاستصحاب، فتأمل.وبالجملة، فأصل البراءه أظهر عند القائلين بها والمنكرين لها من أن يحتاج إلى الاستصحاب.
ومنها: أن الاحتياط عسر منفي وجوبه.
وفيه: أن تعسره إلا من حيث كثرة موارده.فهي ممنوعة، لان مجراها عند الاخباريين موارد فقد النص على الحرمة وتعارض النصوص من غير مرجح منصوص، وهي ليست بحيث يفضي الاحتياط فيها إلى الحرج، وعند المجتهدين موارد فقد الظنون الخاصة.
وهي عند الاكثر ليست بحيث تؤدي الاقتصار عليها والعمل فيما عداها على الاحتياط إلى الحرج.
ولو فرض لبعضهم قلة الظنون الخاصة فلابد له من العلم بالظن الغير المنصوص على حجيته حذرا عن لزوم محذور الحرج.
ويتضح ذلك بما ذكروه في دليل الانسداد الذي أقاموه على وجوب التعدي عن الظنون المخصوصة المنصوصه فراجع.
ومنها: أن الاحتياط قد يتعذر، كما لو دار الامر بين الوجوب والحرمة.
وفيه: ما لا يخفى ولم أر ذكره إلا في كلام شاذ لا يعبأ به.
احتج للقول الثاني - وهو وجوب الكف عما يحتمل الحرمة - بالادلة الثلاثة فمن الكتاب طائفتان إحداهما: ما دل على النهي عن القول بغير علم، فإن الحكم بترخيص الشارع لمحتمل الحرمة قول عليه بغير علم وإفتراء، حيث أنه لم يؤذن فيه.
ولا يرد ذلك على أهل الاحتياط، لانهم لا يحكمون بالحرمة، وإنما يتركون لاحتمال الحرمة.
وهذا بخلاف الارتكاب، فإنه لا يكون إلا بعد الحكم بالرخصة والعمل على الاباحة.
والاخرى: ما دل بظاهره على لزوم الاحتياط والاتقاء والتورع، مثل ما ذكره الشهيد، رحمه الله، في الذكرى في خاتمة قضاء الفوائت للدلاله على مشروعية.الاحتياط في قضاء ما فعلت من الصلوات المحتملة للفساد.
وهي قوله تعالى: (اتقوا الله حق تقاته وجاهدوا في الله حق جهاده).
أقول: ونحوهما في الدلالة على وجوب الاحتياط: (فاتقوا الله ما استطعتم)، وقوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، وقوله تعالى: (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول).
والجواب: أما عن الايات الناهية عن القول بغير علم - مضافا إلى النقض بشبهة الوجوب والشبهة في الموضوع - فبأن الشئ المشتبه حكمه، إتكالا على قبح العقاب من غير بيان المتفق عليه بين المجتهدين والاخباريين، ليس من ذلك.
وأما عما عدا آية التهلكة، فبمنع منافاة الارتكاب للتقوى والمجاهدة، مع أن غايتها الدلالة على الرجحان على ما إستشهد به الشهيد، رحمه الله.
وأما عن آية التهلكة، فبأن الهلاك بمعنى العقاب معلوم العدم، وبمعنى غيره يكون الشبهة موضوعية لا يجب فيها الاجتناب بالاتفاق.
ومن السنة طوائف إحداها: ما دل على حرمة القول والعمل بغير العلم وقد ظهر جوابها مما ذكر في الايات.
والثانية: ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة وعدم العلم وهي لا تحصى كثرة.
وظاهر التوقف المطلق السكون وعدم المضي، فيكون كناية عن عدم الحركة بإرتكاب الفعل.
وهو محصل قوله، عليه السلام، في بعض الاخبار: (الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات).
فلا يرد على الاستدلال: أن التوقف في الحكم الواقعي مسلم عند كلا الفريقين، والافتاء بالحكم الظاهري منعا أو ترخيصا مشترك كذلك.والتوقف في العمل لا معنى له.
فنذكر بعض تلك الاخبار تيمنا: منها: مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبدالله عليه السلام.
وفيها بعد ذكر المرجحات: (إذا كان كذلك فأرجه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة) ونحوها صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام وزاد فيها: (إن لكل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه).
وفي روايات الزهري والسكوني وعبدالاعلى: (الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه).
ورواية أبي شيبة عن أحدهما، عليهما السلام، وموثقة سعد بن زياد عن جعفر، عن أبيه عن آبائه، عن النبي، صلى الله عليه وآله: (إنه قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة، وقفوا عند الشبهة - إلى أن قال - فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة).
وتوهم ظهور هذا الخبر المستفيض في الاستحباب مدفوع بملاحظة أن الاقتحام في الهلكة لا خير فيه أصلا، مع أن جعله تعليلا لوجوب الارجاء في المقبولة وتمهيدا لوجوب طرح ما خالف الكتاب في الصحيحة قرينة على المطلوب.
فمساقة مساق قول القائل: (أترك الاكل يوما خير من أن أمنع منه سنة).
وقوله، عليه السلام، في مقام وجوب الصبر حتى تيقن الوقت: (لان أصلي بعد الوقت أحب إلي من أن أصلي قبل الوقت).
وقوله عليه السلام في مقام التقية: (لان أفطر يوما من شهر رمضان فأقضيه أحب إلي من أن يضرب عنقي).
ونظيره في أخبار الشبهة قول علي، عليه السلام، في وصيته لابنه: (أمسك عن طريق إذا خفت ظلالته، فإن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الاهوال).
ومنها: موثقة حمزة بن طيار: (إنه عرض على أبي عبدالله بعض خطب أبيه، حتى إذا بلغ موضعا منها قال له: كف واسكت.
ثم قال أبوعبدالله عليه السلام: إنه لا يسعكم فيما نزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه والتثبت والرد إلى أئمة الهدى، عليهم السلام، حتى يحملوكم فيه إلى القصد ويجلوا عنكم فيه العمى ويعرفوكم فيه الحق.
قال الله تعالى: فاسألوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون).
ومنها: رواية جميل عن الصادق عن آبائه عليهم السلام: (إنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (الامور ثلاثة، أمر بين لك رشده فخذه، وأمر بين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله عزوجل).
ومنها: رواية جابر عن أبي جعفر، عليه السلام، في وصيته لاصحابه: (إذا إشتبه الامر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح الله لنا).
ومنها: رواية زرارة عن أبي جعفر، عليه السلام: (حق الله على العباد أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا عند ما لا يعلمون).
وقوله، عليه السلام، في رواية المسمعي الواردة في إختلاف الحديثين: (وما لم تجدوا في شئ من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم.
وعليكم الكف والتثبت الوقوف، وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا) إلى غير ذلك مما ظاهره وجوب التوقف.
والجواب: أن بعض هذه الاخبار مختص بما إذا كان المضى في الشبهة إقتحاما في التهلكة.
ولا يكون ذلك إلا مع عدم معذورية الفاعل، لاجل القدرة على إزالة الشبهة بالرجوع إلى الامام، عليه السلام، أو إلى الطرق المنصوبة منه.كما هو ظاهر المقبولة، وموثقة حمزة بن طيار، ورواية جابر، ورواية المسمعي.
وبعضها وارد في مقام النهي عن ذلك، لاتكاله في الامور العملية على الاستنباطات العقلية الظنية، أو لكون المسألة من الاعتقاديات، كصفات الله سبحانه ورسوله والائمة، عليهم السلام، كما يظهر من قوله، عليه السلام، في رواية زرارة: (لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا).
والتوقف في هذه المقامات واجب.
وبعضها ظاهر في الاستحباب، مثل قوله عليه السلام: (أورع الناس من وقف عند الشبهة)، وقوله عليه السلام: (لا ورع كالوقوف عند الشبهة)، وقول أمير المؤمنين عليه السلام: (من ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له أترك.
والمعاصي حمى الله، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها).
وفي رواية نعمان بن بشير قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لكل ملك حمى، وحمى الله حلاله وحرامه والمشتبهات بين ذلك.لو أن راعيا رعى إلى جانب الحمى لم يثبت غنمه أن يقع في وسطه، فدعوا المشتبهات).
وقوله عليه السلام: (من إتقى المشتبهات فقد إستبرأ لدينه).
وملخص الجواب: عن تلك الاخبار أنه لا ينبغي الشك في كون الامر فيها للارشاد من قبيل
أوامر الاطباء المقصود منها عدم الوقوع في المضار، إذ قد تبين فيها حكمة طلب التوقف ولا يترتب على مخالفته عقاب غير ما يترتب على إرتكاب الشبهة أحيانا من الهلاك المحتمل فيها.
فالمطلوب في تلك الاخبار ترك التعرض للهلاك المحتمل في إرتكاب الشبهة.فإن كان ذلك الهلاك المحتمل من قبيل العقاب الاخروي.
كما لو كان التكليف متحققا فعلا في موارد الشبهة، نظير الشبهة المحصورة ونحوها، أو كان المكلف قادرا على الفحص أو إزالة الشبهه بالرجوع إلى الامام، عليه السلام، أو الطرق المنصوبة، أو كانت الشبهة من العقائد والغوامض التي لم يرد الشارع التدين به بغير علم وبصيرة، بل نهى عن ذلك بقوله صلى الله عليه وآله: (إن الله سكت عن أشياء، لم يسكت عنها نسيانا، فلا تتكلفوها، رحمة من الله لكم).
فربما يوقع تكلف التدين فيه بالاعتبارات العقلية والشواذ النقلية إلى العقاب بل إلى الخلود فيه، إذا وقع التقصير في مقدمات تحصيل المعرفة في تلك المسألة: ففي هذه المقامات ونحوها يكون التوقف لازما عقلا وشرعا من باب الارشاد، كأوامر الطبيب بترك المضار.
وإن كان الهلاك المحتمل مفسدة أخرى غير العقاب، سواء كانت دينية، كصيرورة المكلف بإرتكاب الشبهة أقرب إلى إرتكاب المعصية، كما دل عليه غير واحد من الاخبار المتقدمة، أم دنيوية، كالاحتراز عن أموال الظلمة، فمجرد إحتماله لا يوجب العقاب على فعله لو فرض حرمته واقعا.
والمفروض أن الامر بالتوقف في هذه الشبهة لا يفيد إستحقاق العقاب على مخالفته، لان المفروض كونه للارشاد، فيكون المقصود منه التخويف عن لحوق غير العقاب من المضار المحتملة.فإجتناب هذه الشبهة لا يصير واجبا شرعيا بمعنى ترتب العقاب على إرتكابه.
وما نحن فيه، وهي الشبهة الحكمية التحريمية، من هذا القبيل، لان الهلكة المحتملة فيها لا تكون هي المؤاخذة الاخروية بإتفاق الاخباريين، لاعترافهم بقبح المؤاخذة على مجرد مخالفة الحرمة الواقعية المجهولة وإن زعموا ثبوت العقاب من جهة بيان التكليف في الشبهة بأوامر التوقف والاحتياط.
فإذا لم يكن المحتمل فيها هو العقاب الاخروى كان حالها حال الشبهة الموضوعية، كأموال الظلمة والشبهة الوجوبية، في أنه لا يحتمل فيها إلا غير العقاب من المضار والمفروض كون الامر بالتوقف فيها للارشاد والتخويف عن تلك المضرة المحتملة.
وبالجملة، فمفاد هذه الاخبار بأسرها التحذير عن الهلكة المحتملة، فلا بد من إحراز إحتمال الهلكة عقابا كانت أو غيره.
وعلى تقدير إحراز هذا الاحتمال لا إشكال ولا خلاف في وجوب التحرز عنه إذا كان المحتمل عقابا، وإستحبابه إذا كان غيره، فهذه الاخبار لا تنفع في إحداث هذا
الاحتمال ولا في حكمه.
فإن قلت: إن المستفاد منها إحتمال التهلكة في كل محتمل التكليف.
والمتبادر من الهلكة في الاحكام الشرعية الدينية هي الاخروية، فتكشف هذه الاخبار عن عدم سقوط عقاب التكاليف المجهولة لاجل الجهل.
ولازم ذلك إيجاب الشارع الاحتياط، إذ الاقتصار في العقاب على نفس التكاليف المختفيه من دون تكليف ظاهري بالاحتياط قبيح.
قلت: إيجاب الاحتياط إن كان مقدمة للتحرز عن العقاب الواقعي فهو مستلزم لترتب العقاب على التكليف المجهول وهو قبيح، كما اعترفت، وإن كان حكما ظاهريا نفسيا فالهلكة الاخروية مترتبة على مخالفته لا مخالفة الواقع.
وصريح الاخبار إرادة الهلكة الموجودة في الواقع على تقدير الحرمة الواقعية.
هذا كله، مضافا إلى دوران الامر في هذه الاخبار بين حملها على ما ذكرنا وبين إرتكاب التخصيص فيها بإخراج الشبهة الوجوبية والموضوعية.
وما ذكرنا أولى.
وحينئذ فخيرية الوقوف عند الشبهة من الاقتحام في الهلكة أعم من الرجحان المانع من النقيض ومن غير المانع منه.
فهي قضية تستعمل في المقامين.وقد إستعملها الائمة، عليهم السلام، كذلك.
فمن موارد إستعمالها في مقام التوقف: مقبولة عمر بن حنظلة التي جعلت هذه القضية فيها علة لوجوب التوقف في الخبرين المتعارضين عند فقد المرجح، وصحيحة الجميل المتقدمة التي جعلت القضية فيها تمهيدا لوجب طرح ما خالف كتاب الله.
ومن موارد إستعمالها في غير اللازم: رواية الزهري المتقدمة التي جعلت القضيه فيها تمهيدا لترك رواية الخبر الغير المعلوم صدوره أو دلالته، فإن من المعلوم رجحان ذلك لا لزومه.
وموثقة سعد بن زياد المتقدمة التي فيها قول النبي صلى الله عليه وآله: (لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة)، فإن مولانا الصادق، عليه السلام، فسره فتلك الموثقة بقوله عليه السلام: (إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها أو أنها لك محرم، وما أشبه ذلك، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة) الخبر.
ومن المعلوم أن الاحتراز عن نكاح ما في الرواية من النسوة المشتبهة غير لازم بإتفاق
الاخباريين، لكونها شبهة موضوعية ولاصالة عدم تحقق مانع النكاح.
وقد يجاب عن أخبار التوقف بوجوه غير خالية عن النظر: منها: أن ظاهر أخبار التوقف حرمة الحكم والفتوى من غير علم ونحن نقول بمقتضاها، ولكن ندعي علمنا بالحكم الظاهري وهي الاباحة لادلة البراءة.
وفيه: أن المراد بالتوقف - كما يشهد سياق تلك الاخبار وموارد أكثرها - هو التوقف في العمل في مقابل المضي فيه على حسب الارادة الذي هو الاقتحام في الهلكة، لا التوقف في الحكم.
نعم قد يشمله من حيث كون الحكم عملا مشتبها، لا من حيث كونه حكما في شبهة، فوجوب التوقف عبارة عن ترك العمل المشتبه الحكم.
ومنها: أنها ضعيفة السند.
ومنها: أنها في مقام المنع عن العمل بالقياس وأنه يجب التوقف عن القول إذا لم يكن هنا نص من أهل بيت الوحي عليهم السلام.وفي كلا الجوابين ما لا يخفى على من راجع تلك الاخبار.
ومنها: أنها معارضة بأخبار البراءة، وهي أقوى سندا ودلالة وإعتضادا بالكتاب والسنة والعقل.
وغاية الامر التكافؤ، فيرجع إلى ما تعارض فيه النصان، والمختار فيه التخيير، فيرجع إلى اصل البراءة.
وفيه: أن مقتضى أكثر أدلة البراءة المتقدمة - هي جميع آيات الكتاب والعقل وأكثر السنة وبعض تقريرات الاجماع - عدم إستحقاق العقاب على مخالفة الحكم الذي لم يعلمه المكلف.
ومن المعلوم أن هذه من مستقلات العقل الذي لا يدل أخبار التوقف ولا غيرها من الادلة النقلية على خلافه.
وإنما يثبت أخبار التوقف بعد الاعتراف بتماميتها على ما هو المفروض تكليفا ظاهريا بوجوب الكف وترك المضي عند الشبهة والادلة المذكورة لا تنفي هذا المطلب.
فتلك الادلة بالنسبة إلى هذه الاخبار من قبيل الاصل بالنسبة إلى الدليل، فلا معنى لاخذ الترجيح بينهما.
وما يبقى من السنة من قبيل قوله عليه السلام: (كل شئ مطلق) لا يكافئ أخبار التوقف، لكونها
أكثر وأصح سندا.وأما قوة الدلالة في أخبار البراءة فلم يعلم.وظهر أن الكتاب والعقل لا ينافي وجوب التوقف.
وأما ما ذكره من الرجوع إلى التخيير مع التكافؤ، فيمكن للخصم منع التكافؤ، لان أخبار الاحتياط مخالفة للعامة، لاتفاقهم - كما قيل - على البراءة ومنع التخيير على تقدير التكافؤ، لان الحكم في تعارض النصين الاحتياط مع أن التخيير لا يضره، لانه يختار أدلة وجوب الاحتراز عن الشبهات.
ومنها: أن أخبار البراءة أخص، لاختصاصها بمجهول الحلية والحرمة، وأخبار التوقف تشمل كل شبهة فتخصص بأخبار البراءة.
وفيه: ما تقدم، من أن أكثر أدلة البراءة بالاضافة إلى هذه الاخبار من قبيل الاصل والدليل، وما يبقى فإن كان ظاهره الاختصاص بالشبهة الحكمية التحريمية، مثل قوله عليه السلام: (كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي)، فيوجد في أدلة التوقف ما لا يكون أعم منه، فإن ما ورد فيه نهي معارض بما دل على الاباحة غير داخل في هذا الخبر ويشمله أخبار التوقف، فإذا وجب التوقف هنا وجب فيما لا نص فيه بالاجماع المركب، فتأمل.
مع أن جميع موار الشبهة التي أمر فيها بالتوقف لا تخلو عن أن يكون شيئا محتمل الحرمة، سواء كان عملا أو حكما أم إعتقادا، فتأمل.
والتحقيق في الجواب ما ذكرنا.
الثالثة ما دل على وجوب الاحتياط وهي كثيرة منها: صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج: (قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان، الجزاء بينهما أو على كل واحد منها جزاء؟ قال: بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد، فقلت: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك، فلم أدر ما عليه.
قال: إذا أصبتم بمثل هذا ولم تدروا فعليكم الاحتياط حتى تسألوا عنه وتعلموا).
ومنها: موثقة عبدالرحمن بن وضاح، على الاقوى: (قال: كتبت إلى العبد الصالح: يتوارى عنا القرص ويقبل الليل ويزيد الليل إرتفاعا ويستر عنا الشمس ويرتفع فوق الجبل حمرة ويؤذن عندنا
المؤذنون، فأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب عليه السلام: أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحايط لدينك).
فإن الظاهر أن قوله عليه السلام: (وتأخذ) بيان لمناط الحكم.
كما في قولك للمخاطب: (أرى لك أن توفي دينك وتخلص نفسك).فيدل على لزوم الاحتياط مطلقا.
ومنها: ما عن أمالي المفيد الثاني ولد الشيخ، بسند كالصحيح، عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام: (قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لكميل بن زياد: أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت).
وليس في السند إلا علي بن محمد الكاتب الذي يروي عنه المفيد.
ومنها: ما عن حط الشهيد رحمه الله، في حديث طويل عن عنوان البصري، عن أبي عبدالله عليه السلام يقول فيه: (سل العلماء ما جهلت وإياك أن تسألهم تعنتا وتجربة، وإياك أن تعمل برأيك شيئا، وخذ الاحتياط في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلا، واهرب من الفتيا هربك من الاسد، ولا تجعل رقبتك عتبة للناس).
ومنها: ما أرسله الشهيد، رحمه الله، وحكى عن الفريقين من قوله: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإنك لن تجد فقد شئ تركته لله عزوجل).
ومنها: ما أرسله الشهيد، رحمه الله، أيضا من قوله عليه السلام: (لك أن تنظر الحزم وتأخذ بالحايطة لدينك).
ومنها: ما أرسل أيضا عنهم عليهم السلام: (ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط).
والجواب: أما عن (الصحيحة)، فبعدم الدلالة، لان المشار إليه في قوله عليه السلام: (بمثل هذا) إما نفس واقعة الصيد، وإما أن يكون السؤال عن حكمها.
وعلى الاول: فإن جعلنا المورد من قبيل الشك في التكليف، بمعنى أن وجوب نصف الجزاء على كل واحد متيقن ويشك في وجوب النصف الاخر عليه، فيكون من قبيل وجوب أداء
الدين المردد بين الاقل والاكثر، وقضاء الفوائت المرددة.والاحتياط في مثل هذا غير لازم بالاتفاق.لانه شك في الوجوب.
وعلى تقدير قولنا بوجوب الاحتياط في مورد الرواية وأمثاله مما ثبت التكليف فيه في الجملة، لاجل هذه الصحيحة وغيرها، لم يكن ما نحن فيه من الشبهة مماثلا له، لعدم ثبوت التكليف فيه رأسا.
وإن جعلنا المورد من قبيل الشك في متعلق التكليف، وهو المكلف به، لكون الاقل على تقدير وجوب الاكثر غير واجب بالاستقلال، نظير وجوب التسليم في الصلاة، والاحتياط هنا وإن كان مذهب جماعة من المجتهدين أيضا، إلا أن ما نحن فيه من الشبهة الحكمية التحريمية ليس مثلا لمورد الرواية، لان الشك فيه في اصل التكليف.
هذا مع أن ظاهر الرواية التمكن من إستعلام حكم الواقعة بالسؤال والعلم فيما بعد.
ولا مضايقة عن القول بوجوب الاحتياط في هذه الواقعة الشخصية حتى تعلم المسألة لما يستقبل من الوقائع.
ومنه يظهر: أنه إن كان المشار إليه ب (هذا) هو السؤال عن حكم الواقعة - كما هو الثاني من شقي الترديد - فإن أريد بالاحتياط فيه الافتاء بالاحتياط لم ينفع فيما نحن فيه، وإن أريد من الاحتياط الاحتراز عن الفتوى فيها أصلا حتى بالاحتياط فكذلك.
وأما عن (الموثقة): فبأن ظاهرها الاستحباب.
والظاهر أن مراده الاحتياط من حيث الشبهة الموضوعية، لاحتمال عدم إستتار القرص وكون الحمرة المرتفعة أمارة عليها، لان إرادة الاحتياط في الشبهة الحكمية بعيدة عن منصب الامام، عليه السلام، لانه لا يقرر الجاهل بالحكم على جهله.
ولا ريب أن الانتظار مع الشك في الاستتار واجب، لانه مقتضى إستصحاب عدم الليل والاشتغال بالصوم وقاعدة الاشتغال بالصلاة.
فالمخاطب بالاخذ بالحائطة هو الشاك في براءة ذمته عن الصوم والصلاة، ويتعدى منه إلى كل شاك في براءة ذمته عما يجب عليه يقينا، لا مطلق الشاك، لان الشاك في الموضوع الخارجي مع عدم تيقن التكليف لا يجب عليه الاحتياط بإتفاق من الاخباريين أيضا.
هذا كله على تقدير القول بكفاية إستتار القرص في الغروب وكون الحمره غير الحمرة المشرقية.
ويحتمل بعيدا أن يراد من الحمرة الحمرة المشرقية التي لا بد من زالها في تحقق المغرب.
وتعليله حنيئذ بالاحتياط، وإن كان بعيدا عن منصب الامام، عليه السلام، كما لا يخفى، إلا أنه يمكن أن يكون هذا النحو من التعبير لاجل التقية، لايهام أن الوجه في التأخير هو حصول الجزم بإستتار القرص وزوال إحتمال عدمه، لا أن المغرب لا يدخل مع تحقق الاستتار.
كما أن قوله: (أرىلك)، يستشم منه رائحة الاستحباب، فلعل التعبير به مع وجوب التأخير من جهة التقية.
وحينئذ فتوجيه الحكم بالاحتياط لا يدل إلا على رجحانه.
وأما عن رواية الامالي، فبعدم دلالتها على الوجوب، للزوم إخراج أكثر موارد الشبهة، وهي الشبهة الموضوعية مطلقا والحكمية الوجوبية.
والحمل على الاستحباب أيضا مستلزم لاخراج موارد وجوب الاحتياط، فتحمل على الارشاد أو على الطلب المشترك بين الوجوب والندب.
وحينئذ فلا ينافي لزومه في بعض الموارد وعدم لزومه في بعض آخر، لان تأكد الطلب الارشادي وعدمه بحسب المصلحة الموجودة في الفعل، لان الاحتياط هو الاحتراز عن موارد إحتمال المضرة، فيختلف رضاء المرشد بتركه وعدم رضاه بحسب مراتب المضرة كما أن الامر في الاوامر الواردة في إطاعة الله ورسوله للارشاد المشترك بين فعل الواجبات وفعل المندوبات، هذا.
والذي يقتضيه دقيق النظر أن الامر المذكور بالاحتياط لخصوص الطلب الغير الالزامي، لان المقصود منه بيان أعلى مراتب الاحتياط لا جميع مراتبه ولا المقدار الواجب.
والمراد من قوله: (بما شئت)، ليس التعميم من حيث القلة والكثرة والتفويض إلى مشية الشخص، لان هذا كله مناف لجعله بمنزلة الاخ، بل المراد أن أي مرتبة من الاحتياط شئتها فهي في محلها.
وليس هنا مرتبة من الاحتياط لا يستحسن بالنسبة إلى الدين، لانه بمنزلة الاخ الذي هو كذلك وليس بمنزلة سائر الامور لا يستحسن فيها بعض مراتب الاحتياط، كالمال وما عدا الاخ من الرجال.
فهو بمنزلة قوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم).
ومما ذكرنا يظهر الجواب عن سائر الاخبار المتقدمة من ضعف السند في الجميع.
نعم يظهر من المحقق، رحمه الله، في المعارج إعتبار إسناد النبوي: (دع ما يريبك)، حيث اقتصر في رده على: (أنه خبر واحد لا يعول عليه في الاصول، وأن إلزام المكلف بالاثقل مظنة الريبة).
وما ذكره محل تأمل، لمنع كون المسألة اصولية، ثم منع كون النبوي من أخبار الآحاد المجردة، لان مضمونه، وهو ترك الشبهة، يمكن دعوى تواتره، ثم منع عدم إعتبار أخبار الآحاد في المسألة الاصولية.
وما ذكره: من (أن إلزام المكلف بالاثقل، إلخ)، فيه: أن الالزام من هذا الامر، فلا ريبة فيه.
الرابعة أخبار التثليث المروية عن النبي " ص " والوصي " ع " وبعض الائمة " ع " ففي مقبولة إبن حنظلة الواردة في الخبرين المتعارضين - بعد الامر بأخذ المشهور منهما وترك الشاذ النادر، معللا بقوله عليه السلام: (فإن المجمع عليه لا ريب فيه)، قوله: (إنما الامور ثلاثة، أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله ورسوله -.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم).
وجه الدلالة: أن الامام، عليه السلام، أوجب طرح الشاذ معللا بأن المجمع عليه لا ريب فيه.
والمراد أن الشاذ فيه الريب، لا أن الشهرة تجعل الشاذ مما لا ريب في بطلانه، وإلا لم يكن معنى لتأخر الترجيح بالشهرة عن الترجيح بالاعدلية والاصدقية والاورعية، ولا لفرض الراوي الشهرة في كلا الخبرين، ولا لتثليث الامور، ثم إلاستشهاد بتثليث النبي صلى الله عليه وآله.
والحاصل: أن الناظر في الرواية يقطع بأن الشاذ مما فيه الريب فيجب طرحه، وهو الامر المشكل الذي أوجب الامام رده إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله.
فيعلم من ذلك كله أن الاستشهاد بقول رسول الله، صلى الله عليه وآله، في التثليث لا يستقيم إلا مع وجوب الاجتناب عن الشبهات، مضافا إلى دلالة قوله: (نجى من المحرمات)، بناء على أن تخلص النفس من المحرمات واجب، وقوله صلى الله عليه وآله: (وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم).
ودون هذا النبوى في الظهور، النبوي المروي عن ابي عبدالله، عليه السلام، في كلام طويل، و قد تقدم في أخبار التوقف، وكذا مرسلة الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام.
والجواب عنه: ما ذكرنا سابقا، من أن الامر بالاجتناب عن الشبهة إرشادي للتحذير عن المضرة المحتملة فيها، فقد تكون المضرة عقابا.وحينئذ فالاجتناب لازم، وقد تكون مضرة أخرى.
فلا عقاب على إرتكابها على تقدير الوقوع في الهلكة، كالمشتبه بالحرام حيث لا يحتمل فيه الوقوع في العقاب على تقدير الحرمة إتفاقا، لقبح العقاب على الحكم الواقعي المجهول بإعتراف الاخباريين
أيضا، كما تقدم.
وإذا تبين لك أن المقصود من الامر بطرح الشبهات ليس خصوص الالزام، فيكفي حينئذ في مناسبة ذكر كلام النبي، صلى الله عليه وآله، المسوق للارشاد أنه إذا كان الاجتناب عن المشتبه بالحرام راجحا، تفصيا عن الوقوع في مفسدة الحرام، فكذلك طرح الخبر الشاذ واجب، لوجوب التحري عند تعارض الخبرين في تحصيل ما هو أبعد من الريب، وأقرب إلى الحق، إذ لو قصر في ذلك وأخذ بالخبر الذي فيه الريب احتمل أن يكون قد أخذ بغير ما هو الحجة له، فيكون الحكم به حكما من غير الطريقة المنصوبة من الشارع، فتأمل.
ويؤيد ما ذكرنا من أن النبوي ليس واردا في مقام الالزام بترك الشبهات أمور.
أحدها: عموم الشبهات للشبهة الموضوعيه التحريمية التي إعترف الاخباريون بعدم وجوب الاجتناب عنها.
وتخصيصه بالشبهة الحكمية، مع أنه إخراج لاكثر الافراد، مناف للسياق، فإن سياق الرواية آب عن التخصيص، لانه ظاهر في الحصر، وليس الشبهه الموضوعية من الحلال البين.
ولو بني على كونها منه لاجل ادلة جواز إرتكابها، قلنا بمثله في الشبهة الحكمية.
الثاني: أنه، صلى الله عليه وآله، رتب على إرتكاب الشبهة الوقوع في المحرمات والهلاك من حيث لا يعلم.
والمراد جنس الشبهة، لانه في مقام بيان ما تردد بين الحرام والحلال، لا في مقام التحذير عن إرتكاب المجموع.
مع أنه ينافي إستشهاد الامام عليه السلام.
ومن المعلوم أن إرتكاب جنس الشبهة لا يوجب الوقوع في الحرام ولا الهلاك من حيث لا يعلم إلا على مجاز المشارفة، كما يدل عليه بعض ما مضى وما يأتي من الاخبار.
فالاستدلال موقوف على إثبات كبرى، وهي أن الاشراف على الوقوع في الحرام والهلاك من حيث لا يعلم محرم من دون سبق علم به أصلا.
الثالث: الاخبار الكثيرة المساوقة لهذا الخبر الشريف الظاهرة في الاستحباب بقرائن مذكورة فيها: منها: قول النبي، صلى الله عليه وآله، في رواية النعمان، وقد تقدم في أخبار التوقف.
ومنها: قول أمير المؤمنين، عليه السلام في مرسلة الصدوق أنه خطب وقال: (حلال بين و حرام بين وشبهات بين ذلك.
فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما إستبان له أترك، و المعاصي حمى الله، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها).
ومنها: رواية أبي جعفر الباقر عليه السلام: (قال: قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث يأمر بترك الشبهات بين الحلال والحرام: من رعى غنمه قرب الحمى نازعته نفسه إلى أن يرعاها في الحمى.
ألا إن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه، فاتقوا حمى الله و محارمه).
ومنها: ما ورد من: (أن في حلال الدنيا حسابا وفي حرامها عقابا وفي الشبهات عتابا).
ومنها: رواية فضيل بن عياض: (قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: من الورع من الناس؟ قال: الذي يتورع عن محارم الله ويجتنب هؤلاء، فإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه).
وأما العقل فتقريره بوجهين: أحدهما: أنا نعلم إجمالا قبل مراجعة الادلة الشرعية بمحرمات كثيرة يجب - بمقتضى قوله تعالى: (وما نهيكم عنه فانتهوا) ونحوه، - الخروج عن عهدة تركها على وجه اليقين بالاجتناب أو اليقين بعدم العقاب، لان الاشتغال اليقيني يستدعي اليقين بالبراءه بإتفاق المجتهدين والاخبار بعد مراجعة الادلة والعمل بها لا يقطع بالخروج عن جميع تلك المحرمات الواقعية، فلا بد من إجتناب كل ما احتمل أن يكون منها إذا لم يكن هناك دليل شرعي يدل على حليته، إذ مع هذا الدليل يقطع بعدم العقاب على الفعل على تقدير الحرمة واقعا.
فإن قلت: بعد مراجعة الادلة نعلم تفصيلا بحرمة أمور كثيرة ولا نعلم إجمالا بوجود ماعداها، فالاشتغال بما عدى المعلوم تفصيلا غير متيقن، حتى يجب الاحتياط.
وبعبارة أخرى: العلم الاجمالي قبل الرجوع إلى الادلة، وأما بعده فليس هنا علم إجمالي.
قلت: إن اريد من الادلة ما يوجب العلم بالحكم الواقعي الاولي، فكل مراجع في (الفقه) يعلم أن ذلك غير متيسر، لان سند الاخبار لو فرض قطعيا لكن دلالتها ظنية، وإن أريد منها ما يعم الدليل الظني المعتبر من الشارع فمراجعتها لا توجب اليقين بالبراءه من ذلك التكليف المعلوم إجمالا، إذ ليس معنى إعتبار الدليل الظني إلا وجوب الاخذ بمضمونه، فإن كان تحريما صار ذلك.
كأنه أحد المحرمات الواقعية، وإن كان تحليلا كان اللازم منه عدم العقاب على فعله وإن كان في الواقع من المحرمات.
وهذا المعنى لا يوجب إنحصار المحرمات الواقعية.
في مضامين تلك الادلة حتى يحصل العلم بالبراءه بموافقتها، بل ولا يحصل الظن بالبراءة عن جيمع المحرمات المعلومة إجمالا.وليس الظن التفصيلي بحرمة جملة من الافعال كالعلم التفصيلي بها، لان العلم التفصيلي
بنفسه مناف لذلك العلم الاجمالي والظن غير مناف له، لا بنفسه ولا بملاحظة إعتباره شرعا على الوجه المذكور.
نعم لو اعتبر الشارع هذه الادلة بحيث إنقلب التكليف إلى العمل بمؤداها بحيث يكون هو المكلف به كان ما عدا ما تضمنه الادلة من محتملات التحريم خارجا عن المكلف به، فلا يجب الاحتياط فيها.
وبالجملة، فما نحن فيه بمنزلة قطيع غنم نعلم إجمالا بوجود محرمات فيها، ثم قامت البينة على تحريم جملة منها وتحليل جملة، وبقي الشك في جملة ثالثة، فإن مجرد قيام البينة على تحريم البعض لا يوجب العلم ولا الظن بالبراءة من جميع المحرمات.
نعم لو اعتبر الشارع البينة في المقام، بمعنى أنه أمر بتشخيص المحرمات المعلومة وجودا وعدما بهذا الطريق، رجع التكليف إلى وجوب إجتناب ما قامت عليه البينة، لا الحرام الواقعي.
والجواب: أولا، منع تعلق تكليف غير القادر على تحصيل العلم إلا بما يؤدي إليه الطرق الغير العلمية المنصوبة له، فهو مكلف بالواقع بحسب تأديه هذه الطرق، لا بالواقع من حيث هو، ولا بمؤدى هذه الطرق من حيث هو حتى يلزم التوصيب أو ما يشبهه، لان ما ذكرناه هو المحصل من ثبوت الاحكام الواقعيه للعالم وغيره وثبوت التكليف بالعمل بالطرق، وتوضيحه في محله.
وحينئذ فلا يكون ما شك في تحريمه مما هو مكلف به فعلا على تقدير حرمته واقعا.
وثانيا، سلمنا التكليف الفعلي بالمحرمات الواقعية، إلا أن من المقرر في الشبهة المحصورة، كما سيجئ إن شاء الله تعالى، أنه إذا ثبت في المشتبهات المحصورة وجوب الاجتناب عن جملة منها لدليل آخر غير التكليف المتعلق بالمعلوم الاجمالي اقتصر في الاجتناب على ذلك القدر، لاحتمال كون المعلوم الاجمالي هو هذا المقدر المعلوم حرمته تفصيلا.
فأصالة الحل في البعض الاخر غير معارضة بالمثل، سواء كان ذلك الدليل سابقا على العلم الاجمالي، كما إذا علم نجاسة أحد الانائين تفصيلا، فوقع قذرة في أحدهما المجهول، فإنه لا يجب الاجتناب عنه الاخر، لان حرمة أحدهما معلومة تفصيلا، أم كان لاحقا، كما في مثال الغنم المذكور، فإن العلم الاجمالي غير ثابت بعد العلم التفصيلي بحرمة بعضها بواسطة وجوب العمل بالبينة، وسيجئ توضيحه إن شاء الله تعالى، وما نحن فيه من هذا القبيل
الوجه الثاني: أن الاصل في الافعال الغير الضرورية الحظر.
كما نسب إلى طائفة من الامامية، فيعمل به حتى يثبت من الشرع الاباحة، ولم يرد الاباحة فيما لا نص فيه.
وما ورد على تقدير تسليم دلالته معارض بما ورد من الامر بالتوقف والاحتياط، فالمرجع إلى الاصل.
ولو تنزلنا عن ذلك فالوقف، كما عليه الشيخان، واحتج عليه في العدة بأن الاقدام على ما لا يؤمن المفسده فيه كالاقدام على ما يعلم المفسدة فيه.
وقد جزم بهذه القضيه السيد أبوالمكارم في الغنية، وإن قال بالاباحة، كالسيد المرتضى، رحمه الله، تعويلا على قاعدة اللطف وأنه لو كان في الفعل مفسدة لوجب على الحكيم بيانه، لكن رده في العدة بأنه قد يكون المفسدة في الاعلام ويكون المصلحة في كون الفعل على الوقف.
والجواب، بعد تسليم إستقلال العقل بدفع الضرر، أنه إن أريد ما يتعلق بأمر الاخرة من العقاب يجب على الحكيم تعالى بيانه، فهو مع عدم البيان مأمون.وإن أريد غيره مما لا يدخل.
في عنوان المؤاخذة من اللوازم المترتبة مع الجهل أيضا، فوجوب دفعها غير لازم عقلا، إذ العقل لا يحكم بوجوب الاحتراز عن الضرر الدنيوي المقطوع إذ كان لبضع الدواعي النفسانية، وقد جوز الشارع بل أمر به في بعض الموارد.
وعلى تقدير الاستقلال فليس مما يترتب عليه العقاب، لكونه من باب الشبهة الموضوعيه، لان المحرم هو مفهوم الاضرار، وصدقه في هذا المقام مشكوك، كصدق المسكر المعلوم التحريم على هذا المائع الخاص، والشبهة الموضوعية لا يجب الاجتناب عنها بإتفاق الاخباريين أيضا، وسيجئ الكلام في الشبهة الموضوعية إن شاء الله تعالى.
وينبغي التنبيه على أمور الاول أن المحكى عن المحقق التفصيل في إعتبار اصل البراءه بين ما يعم به البلوى وغيره، فيعتبر في الاول دون الثاني.
ولا بد من حكاية كلامه، رحمه الله، في المعتبر والمعارج حتى يتضح حال النسبة.
قال في المعتبر: (الثالث، يعني من أدلة العقل، الاستصحاب، وأقسامه ثلاثة: الاول إستصحاب حال العقل، وهو التمسك بالبراءة الاصلية كما يقال: الوتر ليس واحبا، لان الاصل براءه الذمة.
ومنه أن يختلف العلماء في حكم الدية المترددة بين الاقل والاكثر، كما في دية عين الدابة المترددة بين النصف والربع - إلى أن قال: - الثاني أن يقال: عدم الدليل على كذا فيجب إنتفاؤه.
وهذا يصح فيما يعلم أنه لو كان هنا دليل لظفر به.
أما لا مع ذلك فيجب التوقف، ولا يكون ذلك الاستدلال حجة.
ومنه القول بالاباحة، لعدم دليل الوجوب والحظر.
الثالث إستصحاب حال الشرع.
ثم اختار أنه ليس بحجة)، إنتهى موضع الحاجة من كلامه رحمه الله.
وذكر في المعارج، على ما حكي عنه: (أن الاصل خلو الذمة عن الشواغل الشرعية، فإذا إدعى مدع حكما شرعيا جاز لخصمه أن يتمسك في إنتفائه بالبراءة الاصلية، فيقول: لو كان ذلك الحكم ثابتا لكان عليه دلالة شرعية.
لكن ليس كذلك، فيجب نفيه.
وهذا الدليل لا يتم إلا ببيان مقدمتين: إحداهما أنه لا دلالة عليه شرعا بأن ينضبط طرق الاستدلالات الشرعية ويبين عدم دلالتها عليه.
والثانية أن يبين أنه لو كان هذا الحكم ثابتا لدلت عليه إحدى تلك الدلائل، لانه لو لم يكن عليه دلالة لزم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى العلم به، وهو تكليف بما لا يطاق.
ولو كانت عليه دلالة غير تلك الادلة لما كانت الدلالات منحصرة فيها.
لكنا بينا إنحصار الاحكام في تلك الطرق، وعند ذلك يتم كون ذلك دليلا على نفي الحكم)، إنتهى.
وحكي عن المحدث الاسترابادي في فوائده: (أن تحقيق هذا الكلام هو أن المحدث الماهر إذا تتبع الاحاديث المروية عنهم في مسألة لو كان فيها حكم مخالف للاصل لاشتهر، لعموم البلوى بها.
فإذا لم يظفر بحديث دل على ذلك الحكم ينبغي أن يحكم قطعا عاديا بعدمه، لان جما غفيرا من أفاضل علمائنا أربعة آلاف منهم تلامذة الصادق عليه السلام - كما في المتعبر - كانوا ملازمين لائمتنا، عليهم السلام، في مدة تزيد على ثلاث مائة سنة.
وكان هممهم وهمم الائمة، عليهم السلام، إظهار الدين عندهم وتأليفهم كل ما يسمعون منهم في الاصول، لئلا يحتاج الشيعه إلى سلوك طريق العامة، ولتعمل بما في تلك الاصول في زمان الغيبة الكبرى.
فإن رسول الله صلى الله عليه وآله والائمة، عليهم السلام، لم يضيعوا من في أصلاب الرجال من شيعتهم، كما في الروايات المتقدمة.
ففي مثل تلك الصورة يجوز التمسك بأن نفي ظهور دليل على حكم مخالف للاصل دليل على عدم ذلك الحكم في الواقع - إلى أن قال - ولا يجوز التمسك في غير المسألة المفروضة إلا عند العامة القائلين بأنه " ص " أظهر عند أصحابه كل ما جاء به وتوفرت الدواعى على جهة واحدة على نشره وما خص " ص " أحدا بتعليم شئ لم يظهره عند غيره، ولم يقع بعده ما اقتضى اختفاء ما جاء به)، إنتهى.
أقول: المراد بالدليل المصحح للتكليف، حتى لا يلزم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى العلم به، هو ما تيسر للمكلف الوصول إليه والاستفادة منه.
فلا فرق بين ما لم يكن في الواقع دليل شاف أصلا أو كان ولم يتمكن المكلف من الوصول إليه أو تمكن لكن بمشقة رافعة للتكليف، أو تيسر ولم يتم دلالته في نظر المستدل، فإن الحكم الفعلي في جميع هذه الصور قبيح على ما صرح به المحقق،
رحمه الله، في كلامه السابق، سواء قلنا بأن وراء الحكم الفعلي حكما أخر يسمى حكما واقعيا أو حكما شأنيا على ما هو مقتضى مذهب المخطئة، أم قلنا بأنه ليس وراءه حكم آخر، للاتفاق على أن مناط الثواب والعقاب ومدار التكليف هو الحكم الفعلي.
وحينئذ فكل ما تتبع المستنبط في الادلة الشرعية في نظره إلى أن علم من نفسه عدم تكليفه بأزيد من هذا المقدار من التتبع، ولم يجد فيها ما يدل على حكم مخالف للاصل، صح له دعوى القطع بإنتفاء الحكم الفعلي.
ولا فرق في ذلك بين العام البلوى وغيره، ولا بين العامة والخاصة، و لا بين المخطئة والمصوبة، ولا بين المجتهدين والاخباريين، ولا بين أحكام الشرع وغيرها من أحكام سائر الشرائع وسائر الموالي بالنسبة إلى عبيدهم.
هذا بالنسبة إلى الحكم الفعلي.
وأما بالنسبة إلى الحكم الواقعي النازل به جبرئيل على النبي، صلى الله عليه وآله، لو سميناه حكما بالنسبة إلى الكل، فلا يجوز الاستدلال على نفيه ما ذكره المحقق، رحمه الله، من لزوم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى العلم به، لان المفروض عدم إناطة التكليف به.
نعم قد يظن من عدم وجدان الدليل عليه بعدمه بعموم البلوى به، لا بمجرده، بل مع ظن عدم المانع من نشره في أول الامر من الشارع أو خلفائه أو من وصل إليه.
لكن هذا الظن لا دليل على إعتباره، ولا دخل له بأصل البراءة التي هي من الادلة العقلية، ولا بمسألة التكليف بما لا يطاق، ولا بكلام المحقق، رحمه الله، فما تخيله الحدث تحقيقا لكلام المحقق رحمه الله، مع أنه غير تام في نفسه، أجنبي عنه بالمرة.
نعم قد يستفاد من إستصحاب البراءة السابقة الظن بها فيما بعد الشرع، كما سيجئ عن بعضهم.
لكن لا من باب التكليف بما لا يطاق الذي ذكره المحقق رحمه الله.
ومن هنا يعلم أن تغاير القسمين الاولين من الاستصحاب بإعتبار كيفية الاستدلال، حيث أن مناط الاستدلال في هذا القسم الملازمه بين عدم الدليل وعدم الحكم مع قطع النظر عن ملاحظة الحالة السابقة.
فجعله من أقسام الاستصحاب مبني على إرادة مطلق الحكم على طبق الحالة السابقة عند الشك ولو لدليل آخر غير الاتكال على الحالة السابقة، فيجري فيما لم يعلم فيه الحالة السابقة، ومناط الاستدلال في القسم الاول ملاحظة الحالة السابقة حتى مع عدم العلم بعدم الدليل على الحكم.
ويشهد لما ذكرنا من المغايرة الاعتبارية أن الشيخ لم يقل بوجوب مضي المتيمم الواجد للماء في أثناء صلاته لاجل الاستصحاب، وقال به لاجل أن عدم الدليل دليل العدم.
نعم هذا القسم
الثاني أعم موردا من الاول، لجريانه في الاحكام العقلية وغيرها، كما ذكره جماعة من الاوصوليين.
والحاصل: أنه لا ينبغي الشك في أن بناء المحقق، رحمه الله، على التمسك بالبراءة الاصلية مع الشك في الحرمة، كما يظهر من تتبع فتاويه في المعتبر.
الثاني: مقتضى الادلة المتقدمة كون الحكم الظاهري في الفعل المشتبه الحكم هي الاباحة من غير ملاحظة الظن بعدم تحريمه في الواقع.فهذا الاصل يفيد القطع بعدم إشتغال الذمة، لا الظن بعدم الحكم واقعا، ولو أفاده لم يكن معتبرا.
إلا أن الذي يظهر من جماعة كونه من الادلة الظنية، منهم صاحب المعالم، رحمه الله، عند دفع الاعتراض عن بعض مقدمات الدليل الرابع الذي ذكره لحجية خبر الواحد، ومنهم شيخنا البهائي رحمه الله.
ولعل هذا هو المشهور بين الاصوليين، حيث لا يتسمكون فيها إلا باستصحاب البراءة السابقة، بل ظاهر المحقق، رحمه الله، في المعارج الاطباق على التمسك بالبراءة الاصلية حتى يثبت الناقل.
و ظاهره أن إعتمادهم في الحكم بالبراءة على كونها هي الحالة السابقة الاصلية.
والتحقيق أنه لو فرض حصول الظن من الحالة السابقة فلا يعتبر، والاجماع ليس على إعتبار هذا الظن.
وإنما هو العمل على طبق الحالة السابقة ولا يحتاج إليه بعد قيام الاخبار المتقدمة و حكم العقل.
الثالث: لا إشكال في رجحان الاحتياط عقلا ونقلا، كما يستفاد من الاخبار المذكورة وغيرها.
وهل الاوامر الشرعية للاستحباب فيثاب عليه وإن لم يحصل به الاجتناب عن الحرام الواقعي، أو غيرى، بمعنى كونه مطلوبا لاجل التحرز عن الهلكة المحتملة والاطمينان بعدم وقوعه فيها، فيكون الامر به إرشاديا لا يترتب عليه موافقته ومخالفته سوى الخاصية المترتبة على الفعل أو الترك، نظير أوامر الطبيب، ونظير الامر بالاشهاد عند المعاملة لئلا يقع التنازع؟ وجهان، من ظاهر الامر بعد فرض عدم إرادة الوجوب، ومن سياق جل الاخبر الواردة في ذلك.فإن الظاهر كونها مؤكدة لحكم العقل بالاحتياط.
والظاهر أن حكم العقل بالاحتياط من حيث هو احتياط على تقدير كونه إلزاميا لمحض الاطمينان ودفع إحتمال العقاب.
وكما أنه إذا تيقن بالضرر يكون إلزام العقل لمحض الفرار عن العقاب المتيقن، فكذلك طلبه
الغير الالزامي إذا احتمل الضرر.
بل وكما أن أمر الشارع بالاطاعة في قوله تعالى: (أطيعوا الله ورسوله) لمحض الارشاد، لئلا يقع العبد في عقاب المعصية ويفوته ثواب الطاعة ولا يترتب على مخالفته سوى ذلك، فكذلك أمره بالاخذ بما يأمن معه الضرر لا يترتب على موافقته سوى الامان المذكور، ولا على مخالفته سوى الوقوع في الحرام الواقعي على تقدير تحققه.
ويشهد لما ذكرنا أن ظاهر الاخبار حصر حكمة الاجتناب عن الشبهة في التفصي عن الهلكة الواقعية لئلا يقع فيها من حيث لا يعلم وإقترانه مع الاجتناب عن الحرام المعلوم في كونه ورعا.
ومن المعلوم أن الامر بإجتناب المحرمات في هذه الاخبار ليس إلا للارشاد، لا يترتب على مخالفتها وموافقتها سوى الخاصية الموجودة في المأمور به، وهو الاجتناب عن الحرام أو فوتها.
فكذلك الامر بإجتناب الشبهة لا يترتب على موافقته سوى ما يترتب على نفس الاجتناب لو لم يأمر به الشارع، بل فعل المكلف حذرا من الوقوع في الحرام.ولا يبعد التزام ترتب الثواب عليه، من حيث أنه إنقياد وإطاعة حكمية.
فيكون حينئذ حال الاحتياط والامر به حال نفس الاطاعة الحقيقية، والامر بها في كون الامر لا يزيد فيه على ما ثبت فيه من المدح أو الثواب لولا الامر، هذا.
ولكن الظاهر من بعض الاخبار المتقدمة، مثل قوله عليه السلام: (من إرتكب الشبهات نازعته نفسه إلى أن يقع في المحرمات)، وقوله: (من ترك الشبهات كان لما إستبان له من الاثم أترك)، وقوله: (من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه)، هو كون الامر به للاستحباب.و حكمته أن لا يهون عليه إرتكاب المحرمات المعلومة.
ولازم ذلك إستحقاق الثواب على إطاعة أوامر الاحتياط مضافا إلى الخاصية المترتبة على نفسه.
ثم لا فرق فيما ذكرناه من حسن الاحتياط بالترك بين أفراد المسألة حتى مورد دوران الامر بين الاستحباب والتحريم، بناء على أن دفع المفسدة الملزمه للترك أولى من جلب المصلحة الغير الملزمة و ظهور الاخبار المتقدمة في ذلك أيضا.
ولا يتوهم: (أنه يلزم من ذلك عدم حسن الاحتياط فيما احتمل كونه من العبادات المستحبة بل حسن الاحتياط بتركه)، إذ لا ينفك ذلك عن إحتمال كون فعله تشريعا محرما، لان حرمة التشريع تابعة لتحققه.
ومن إتيان ما احتمل كونه عبادة لداعي هذا الاحتمال لا يتحقق موضوع التشريع.
ولذا قد يجب الاحتياط مع هذا الاحتمال، كما في الصلاة إلى أربع جهات أو في الثوبين
المشتبهين وغيرهما.وسيجئ زيادة توضيح لذلك إن شاء الله.
الرابع: نسب الوحيد البهبهاني، رحمه الله، إلى الاخباريين مذاهب أربعة فيما لا نص فيه: التوقف، و الاحتياط، والحرمة الظاهرية، والحرمة الواقعية، فيحتمل رجوعها إلى معنى واحد وكون إختلافها في التعبير، لاجل إختلاف ما ركنوا إليه من أدلة القول بوجوب إجتناب الشبهة: فبعضهم ركن إلى أخبار التوقف، وآخر إلى أخبار الاحتياط، وثالث إلى أوامر ترك الشبهات مقدمة لتجنب المحرمات، كحديث التثليث، ورابع إلى أوامر ترك المشتبهات من حيث أنها مشتبهات، فإن هذا الموضوع في نفسه حكمه الواقعي الحرمة.
والاظهر أن التوقف أعم بحسب المورد من الاحتياط، لشموله الاحكام المشتبهة في الاموال و الاعراض والنفوس مما يجب فيها الصلح أو القرعة.فمن عبر به أراد وجوب التوقف في جميع الوقائع الخالية عن النص العام والخاص.
والاحتياط اعم من موارد إحتمال التحريم.
فمن عبر به أراد الاعم من محتمل التحريم ومحتمل الوجوب، مثل وجوب السورة أو وجوب الجزاء المردد بين نصف الصيد وكله.
وأما الحرمة الظاهرية والواقعيه فيحتمل الفرق بينهما: بأن المعبر بالاولى قد لاحظ الحرمة من حيث عروضها لموضوع محكوم بحكم واقعي، فالحرمة ظاهرية.
والمعبر بالثانية قد لاحظها من حيث عروضها لمشتبه الحكم، وهو موضوع من الموضوعات الواقعية، فالحرمة واقعية.
أو بملاحظة أنه إذا منع الشارع المكلف، من حيث أنه جاهل بالحكم من الفعل، فلا يعقل إباحته له واقعا، لان معنى الاباحة الاذن والترخيص، فتأمل.
ويحتمل الفرق بأن القائل بالحرمة الظاهرية يحتمل أن يكون الحكم في الواقع هي الاباحة، إلا أن أدلة الاجتناب عن الشبهات حرمتها ظاهرا، والقائل بالحرمه الواقعية إنما يتمسك في ذلك باصالة الحظر في الاشياء من قبح باب التصرف فيما يختص بالغير بغير إذنه.
ويحتمل الفرق بأن معنى الحرمة الظاهرية حرمة الشئ في الظاهر فيعاقب عليه مطلقا وإن كان مباحا في الواقع.
والقائل بالحرمة الواقعيه يقول بأنه لا حرمة ظاهرا أصلا.
فإن كان في الواقع حراما إستحق المؤاخذة عليه وإلا فلا.
وليس معناها أن المشتبه حرام واقعا، بل معناه أنه ليس فيه إلا الحرمة الواقعيه على تقدير ثبوتها.
فإن هذا أحد الاقوال للاخباريين في المسألة، على ما ذكر العلامة الوحيد المتقدم، في موضع آخر، حيث قال، بعد رد التثليث المتقدم: ب (أنه لا يدل على
الحظر أو وجوب التوقف، بل مقتضاه أن من إرتكب شبهة واتفق كونه حراما في الواقع يهلك لا مطلقا.
ويخطر بخاطري أن من الاخباريين من يقول بهذا المعنى)، إنتهى.
ولعل هذا القائل اعتمد في ذلك على ما ذكرنا سابقا، من أن الامر العقلي والنقلي بالاحتياط للارشاد، من قبيل أوامر الطبيب، لا يترتب على موافقتها ومخالفتها عدا ما يترتب على نفس الفعل المأمور به أو تركه لو لم يكن أمر، نعم الارشاد على مذهب هذا الشخص على وجه اللزوم، كما في بعض أوامر الطبيب، لا للاولوية، كما اختاره القائلون بالبراءة.وأما ما يترتب على نفس الاحتياط فليس إلا التخلص من الهلاك المحتمل في الفعل.
نعم فاعله يستحق المدح من حيث تركه لما يحتمل أن يكون تركه مطلوبا عند المولى.
ففيه نوع من الانقياد ويستحق عليه المدح والثواب.
وأما تركه فليس فيه إلا التجري بإرتكاب ما يحتمل أن يكون مبغوضا للمولى، ولا دليل على حرمه التجري على هذا الوجه وإستحقاق العقاب عليه.
بل عرفت في مسألة حجية العلم المناقشة في حرمه التجري بما هو أعظم من ذلك، كأن يكون الشئ مقطوع الحرمة بالجهل المركب ولا يلزم من تسليم إستحقاق الثواب على الانقياد بفعل الاحتياط إستحقاق العقاب بترك الاحتياط والتجري بالاقدام على ما يحتمل كونه مبغوضا.وسيأتي تتمة توضيح ذلك في الشبهة المحصورة إن شاء الله تعالى.
الخامس: إن أصل الاباحة في مشتبه الحكم إنما هو مع عدم أصل موضوعي حاكم عليه.
فلو شك في حل أكل حيوان مع العلم بقبوله التذكية جرى أصالة الحل، وإن شك فيه من جهة الشك في قبوله للتذكيه فالحكم الحرمة، لاصالة عدم التذكية، لان من شرائطها قابلية المحل وهي مشكوكة فيحكم بحرمتها وكون الحيوان ميتة.
ويظهر من المحقق والشهيد الثانيين، قدس سرهما، فيما إذا شك في حيوان متولد من طاهر و نجس لا يتبعهما في الاسم وليس له مماثل، أن الاصل فيه الطهارة والحرمة.
فإن كان الوجه فيه أصالة عدم التذكية، فإنما يحسن مع الشك في قبول التذكية وعدم عموم يدل على جواز تذكية كل حيوان إلا ما خرج، كما إدعاه بعض.وإن كان الوجه فيه أصالة حرمة أكل لحمه قبل التذكية.
ففيه: أن الحرمة قبل التذكية لاجل
كونه من الميتة.فإذا فرض إثبات جواز تذكيته خرج عن الميتة فيحتاج حرمته إلى موضوع آخر.ولو شك في قبول التذكية رجع إلى الوجه السابق.وكيف كان فلا يعرف وجه لرفع اليد عن أصالة الحل والاباحة.
نعم ذكر شارح الروضة هنا وجها آخر، ونقله بعض محشيها عن تمهيد القواعد.
قال شارح الروضة: (إن كلا من النجاسات والمحللات محصورة.
فإذا لم يدخل في المحصور منها كان الاصل طهارته وحرمة لحمه، وهو ظاهر)، إنتهى.
ويمكن منه حصر المحللات بل المحرمات محصورة، والعقل والنقل دل على إباحة ما لم يعلم حرمته.
ولذا يتمسكون كثيرا بأصالة الحل في باب الاطعمة والاشربة.
ولو قيل: إن الحل إنما علق، في قوله تعالى: (قل أحل لكم الطيبات) المفيد للحصر في مقام الجواب عن الاستفهام، فكل ما شك في كونه طيبا فالاصل عدم إحلال الشارع له.
قلنا: إن التحريم محمول في القرآن على الخبائث والفواحش.فإذا شك فيه فالاصل عدم التحريم.
ومع تعارض الاصلين يرجع إلى أصالة الاباحة، وعموم قوله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحي إلي)، وقوله عليه السلام: (ليس الحرام إلا ما حرم الله تعالى)، مع أنه يمكن فرض كون الحيوان مما ثبت كونه طيبا، بل الطيب ما لا يستقذر، فهو أمر عدمي يمكن إحرازه بالاصل عند الشك، فتدبر.
السادس: حكي عن بعض الاخباريين كلام لا يخلو إيراده عن فائدة وهو: (أنه هل يجوز أحد أن يقف عبد من عباد الله، فيقال له: بما كنت تعمل في الاحكام الشرعية.
فيقول: كنت أعمل بقول المعصوم وأقتفي أثره وما يثبت من المعلوم.فإن إشتبه علي شئ عملت بالاحتياط.
أفيزل قدم هذا العبد عن الصراط ويقابل بالاهانة والاحباط فيؤمر به إلى النار ويحرم مرافقة الابرار.
هيهات هيهات أن يكون أهل التسامح والتساهل في الدين في الجنة خالدين واهل الاحتياط في النار معذبين)، إنتهى كلامه.
أقول: لا يخفى على العوام فضلا عن غيرهم أن أحدا لا يقول بحرمة الاحتياط ولا ينكر حسنه و
أنه سبيل النجاة.
وأما الافتاء بوجوب الاحتياط فلا إشكال في أنه غير مطابق للاحتياط، لاحتمال حرمته، فإن ثبت وجوب الافتاء فالامر يدور بين الوجوب والتحريم، وإلا فالاحتياط في ترك الفتوى.وحينئذ فيحكم الجاهل بما يحكم به عقله.
فإن إلتفت إلى قبح العقاب من غير بيان لم يكن عليه بأس في إرتكاب المشتبه، وإن لم يلتفت إليه واحتمل العقاب كان مجبولا على الالتزام بتركه.كمن احتمل أن فيما يريد سلوكه من الطريق سبعا.
وعلى كل تقدير فلا ينفع قول الاخباريين له إن العقل يحكم بوجوب الاحتياط من باب وجوب دفع الضرر المحتمل، ولا قول الاصولي له إن العقل يحكم بنفي البأس مع الاشتباه.
وبالجملة فالمجتهدون لا ينكرون على العامل بالاحتياط.
والافتاء بوجوبه من الاخباريين نظير الافتاء بالبراءة من المجتهدين، ولا متيقن من الامرين في البين، ومفاسد الالتزام بالاحتياط ليست بأقل من مفاسد إرتكاب المشتبه، كما لا يخفى.
فما ذكره هذا الاخباري من الانكار لم يعلم توجهه إلى أحد، والله العالم وهو الحاكم.
المسألة الثانية: ما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب من جهة إجمال النص إما بأن يكون اللفظ الدال على الحكم مجملا، كالنهي المجرد عن القرينة إذا قلنا بإشتراكه لفظا بين الحرمة والكراهة، وإما بأن يكون الدال على متعلق الحكم كذلك، سواء كان الاجمال في وضعه كالغناء إذا قلنا بإجماله فيكون المشكوك في كونه غناء محتمل الحرمة، أم كان الاجمال في المراد منه، كما إذا شك في شمول الخمر للخمر الغير المسكر ولم يكن هناك إطلاق يؤخذ به.و الحكم في ذلك كله كما في المسألة الاولى.والادلة المذكورة من الطرفين جارية هنا.
وربما يتوهم أن الاجمال إذا كان في متعلق الحكم، كالغناء وشرب الخمر الغير المسكر، كان ذلك داخلا في الشبهة في طريق الحكم.وهو فاسد.
المسألة الثالثة: أن يدور حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب من جهة تعارض النصين وعدم ثبوت ما يكون مرجحا لاحدهما والاقوى فيه أيضا عدم وجوب الاحتياط، لعدم الدليل عليه، عدا ما تقدم من الوجوه المذكورة التي عرفت حالها، وبعض ما ورد في خصوص تعارض النصين، مثل ما في عوالي اللئالي من مرفوعة العلامة، رحمه الله، إلى زرارة عن مولانا أبي جعفر عليه السلام.
(قال: قلت: جعلت فداك ! يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان، فبأيهما آخذ؟ فقال: يا زرارة ! خذ بما اشتهر بين أصحابك واترك الشاذ النادر.
فقلت: يا سيدي ! إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم.
فقال: خذ بما يقوله
أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك فقلت: إنهما معا عدلان مرضيان موثقان عندي فقال: أنظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم، فإن الحق فيما خالفهم.
قلت: ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين لهم، فكيف نصنع؟ قال: فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط.
فقلت: إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان، فكيف أصنع قال: إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الاخر)، الحديث.
وهذه الرواية وإن كانت أخص من أخبار التخيير، إلا أنها ضعيفة السند: وقد طعن صاحب الحدائق فيها وفي كتاب العوالي وصاحبه، فقال: (إن الروايه المذكورة لم نقف عليها في غير كتاب العوالي، مع ما هي عليها من الارسال، وما عليه الكتاب المذكور من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الاخبار والاهمال وخلط غثها بسمينها وصحيحها بسقيمها، كما لا يخفى على من لاحظ الكتاب المذكور)، إنتهى.
ثم إذا لم نقل بوجوب الاحتياط، ففي كون أصل البراءة مرجحا لما يوافقه أو كون الحكم الوقف أو التساقط والرجوع إلى الاصل أو التخيير بين الخبرين في أول الامر أو دائما وجوه، ليس هنا محل ذكرها، فإن المقصود هنا نفي وجوب الاحتياط، والله العالم.
بقي هنا شئ: وهو أن الاصوليين عنونوا في باب التراجيح الخلاف في تقديم الخبر الموافق للاصل على المخالف، ونسب تقديم المخالف وهو المسمى بالناقل إلى أكثر الاصوليين، بل إلى جمهور منهم العلامة، قدس سره، وعنونوا أيضا مسألة تقديم الخبر الدال على الاباحة على الدال على الحظر و الخلاف فيه، ونسب تقديم الحاظر على المبيح إلى المشهور، بل يظهر من المحكي عن بعضهم عدم الخلاف في ذلك.
والخلاف المسألة الاولى ينافي الوفاق في الثانية.
كما أن قول الاكثر فيهما مخالف لما يشاهد من عمل علمائنا على عدم تقديم المخالف للاصل، بل التخيير أو الرجوع إلى الاصل الذي هو وجوب الاحتياط عند الاخباريين والبراءة عند المجتهدين حتى العلامة، مضافا إلى ذهاب جماعة من أصحابنا في المسألتين إلى التخيير.
ويمكن أن يقال: إن مرادهم من الاصل في الناقل والمقرر أصالة البرءة من الوجوب، لا اصالة الاباحة، فيفارق مسألة تعارض المبيح والحاظر، وإن حكم أصحابنا بالتخيير أو الاحتياط، لاجل الاخبار الواردة، لا لمقتضي نفس مدلولى الخبرين من حيث هما فيفارق المسألتين.لكن هذا الوجه قد يأباه مقتضى أدلتهم، فلاحظ وتأمل.
المسألة الرابعة: دوران الحكم بين الحرمة وغير الوجوب، مع كون الشك في الواقعة الجزئية لاجل الاشتباه في بعض الامور الخارجية كما إذا شك في حرمة شرب مايع أو إباحته، للتردد في أنه خل أو خمر، وفي حرمة لحم، لتردده بين كونه من الشاة أو من الارنب.
والظاهر عدم الخلاف في أن مقتضى الاصل فيه الاباحة، للاخبار الكثيرة في ذلك، مثل قوله عليه السلام: (كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام)، و: كل شئ فيه حلال و حرام فهو لك حلال.
واستدل العلامة، رحمه الله، في التذكرة على ذلك برواية مسعدة بن صدقة: (كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك.
و ذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقة، أو العبد يكون عندك لعله حر قد باع نفسه، أو قهر فبيع، أو خدع فبيع، أو إمرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة).
وتبعه عليه جماعة من المتأخرين، ولا إشكال في ظهور صدرها في المدعى إلا أن الامثلة المذكورة فيها ليس الحل فيها مستندا إلى أصالة الحلية.
فإن الثوب والعبد إن لوحظا بإعتبار اليد عليهما حكم بحل التصرف فيهما لاجل اليد، وإن لوحظا مع قطع النظر عن اليد كان الاصل فيهما حرمة التصرف، لاصالة بقاء الثوب على ملك الغير وأصالة الحرية في الانسان المشكوك في رقيته.وكذا الزوجة إن لوحظ فيها أصل عدم تحقق النسب أو الرضاع.فالحلية مستندة إليه.وإن قطع النظر عن هذا الاصل فالاصل عدم تأثير العقد فيها، فيحرم وطيها.وبالجملة، فهذه الامثلة الثلاثة بملاحظة الاصل الاولي محكومة بالحرمة.والحكم بحليتها إنما هو
من حيث الاصل الموضوعى الثانوي، فالحل غير مستند إلى أصالة الاباحة في شئ منها.
هذا، ولكن في باقي الاخبار المتقدمة بل جميع الادلة المتقدمة من الكتاب والعقل كفاية، مع أن صدرها وذيلها ظاهران في المدعى.
وتوهم: (عدم جريان قبح التكليف من غير بيان هنا، نظرا إلى أن الشارع بين حكم الخمر، مثلا، فيجب حينئذ إجتناب كل ما يحتمل كونه خمرا من باب المقدمة العلمية، فالعقل لا يقبح العقاب خصوصا على تقدير مصادفة الحرام)، مدفوع بأن النهي عن الخمر يوجب حرمة الافراد المعلومة تفصيلا والمعلومة إجمالا بين محصورين.
فالاول لا يحتاج إلى مقدمة علمية والثاني يتوقف على الاجتناب من أطراف الشبهة لا غير.
وأما ما احتمل كونه خمرا من دون علم إجمالي، فلم يعلم من النهي تحريمه وليس مقدمة للعلم بإجتناب فرد محرم يحسن العقاب عليه.
فلا فرق بعد فرض عدم العلم بحرمته ولا بتحريم خمر يتوقف العلم بإجتنابه على إجتنابه بين هذا الفرد المشتبه وبين الموضوع الكلي المشتبه حكمه كشرب التتن في قبح العقاب عليه.
وما ذكر من التوهم جار فيه أيضا، لان العمومات الدالة على حرمة الخبائث والفواحش و (ما نهاكم عنه فانتهوا) تدل على حرمة أمور واقعية يحتمل كون شرب التتن منها.
ومنشأ التوهم المذكور ملاحظة تعلق الحكم بكلي مردد بين مقدار معلوم وبين أكثر منه، فيتخيل أن الترديد في المكلف به فمع العلم بالتكليف يجب الاحتياط.
ونظير هذا التوهم قد وقع في الشبهة الوجوبية حيث تخيل بعض أن دوران ما فات من الصلاة بين الاقل والاكثر موجب للاحتياط من باب وجوب المقدمة العلمية، وقد عرفت، وسيأتى إندفاعه.
قإن قلت: الضرر محتمل في هذا الفرد المشتبه، لاحتمال كونه محرما، فيجب دفعه.
قلت: إن أريد بالضرر العقاب وما يجري مجراه من الامور الاخروية فهو مأمون بحكم العقل بقبح العقاب من غير بيان، وإن اريد ما لا يدفع العقل ترتبه من غير بيان، كما في المضار الدنيوية، فوجوب دفعه عقلا لو سلم - كما تقدم من الشيخ وجماعة - لم يسلم وجوبه شرعا، لان الشارع صرح بحليته ما لم يعلم حرمته، فلا عقاب عليه، كيف وقد يحكم الشرع بجواز إرتكاب الضرر القطعي الغير المتعلق بأمر المعاد، كما هو المفروض في الضرر المحتمل في المقام.
فإن قيل: نختار أولا، إحتمال الضرر المتعلق بأمور الآخرة، والعقل لا يدفع ترتبه من دون بيان، لاحتمال المصلحة في عدم البيان ووكول الامر إلى ما يقتضيه العقل.كما صرح في العدة في جواب
ما ذكره القائلون باصالة الاباحة، من أنه لو كان هناك في الفعل مضرة آجله لبينها.
وثانيا، المضرة الدنيوية، وتحريمه ثابت شرعا، لقوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، كما إستدل به الشيخ أيضا في العدة على دفع أصالة الاباحة.
وهذا الدليل ومثله رافع للحلية الثابتة بقولهم عليهم السلام: (كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام).
قلت: لو سلمنا إحتمال المصلحة في عدم بيان الضرر الاخروي، إلا أن قولهم عليهم السلام: (كل شئ لك حلال) بيان لعدم الضرر الاخروي.
وأما الضرر الغير الاخروي، فوجوب دفع المشكوك منه ممنوع، وآية التهلكة مختصة بمظنة الهلاك وقد صرح الفقهاء في باب المسافر بأن سلوك الطريق الذي يظن معه العطب معصية، دون مطلق ما يحتمل فيه ذلك.
وكذا في باب التيممم والافطار لم يرخصوا إلا مع ظن الضرر الموجب لحرمة العبادة دون الشك.
نعم ذكر قليل من متأخري المتأخرين إنسحاب حكم الافطار والتيمم مع الشك أيضا.
لكن لا من جهة حرمة إرتكاب مشكوك الضرر، بل لدعوى تعلق الحكم في الادلة بخوف الضرر الصادق مع الشك، بل مع بعض أفراد الوهم أيضا.
لكن الانصاف إلزام العقل بدفع الضرر المشكوك فيه، كالحكم بدفع الضرر المتيقن كما يعلم بالوجدان عند وجود مايع محتمل السمية إذا فرض تساوي الاحتمالين من جميع الوجوه.
لكن حكم العقل بوجوب دفع الضرر المتيقن إنما هو بملاحظة نفس الضرر الدنيوى من حيث هو، كما يحكم وجوب دفع الضرر الاخروي كذلك: إلا أنه قد يتحد مع الضرر الدنيوي عنوان يترتب عليه نفع أخروي، فلا يستقل العقل بوجوب دفعه، ولذا لا ينكر العقل أمر الشارع بتسليم النفس للحدود والقصاص وتعريضها له في الجهاد والاكراه على القتل أو على الارتداد.وحينئذ فالضرر الدنيوي المقطوع يجوز أن يبيحه الشارع لمصلحة.
فإباحته للضرر المشكوك لمصحلة الترخيص على العباد أو لغيرها من المصالح أولى بالجواز: فإن قلت: إذا فرضنا قيام أمارة غير معتبرة على الحرمة فيظن الضرر فيجب دفعه مع إنعقاد الاجماع على عدم الفرق بين الشك والظن الغير المعتبر.
قلنا: الظن بالحرمة لا يستلزم الظن بالضرر.أما الاخروي فلان المفروض عدم البيان فيقبح.
و أما الدنيوي فلان الحرمة لاتلازم الضرر الدنيوي، بل القطع بها أيضا لا يلازمه، لاحتمال إنحصار المفسدة فيما يتعلق بالامور الاخروية.
ولو فرض حصول الظن بالضرر الدنيوي فلا محيص عن إلتزام حرمته، كسائر ما ظن فيه الضرر الدنيوي من الحركات والسكنات.
وينبغي التنبيه على أمور الاول إن محل الكلام في الشبهة الموضوعية المحكومة بالاباحة ما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي يقضي بالحرمة.
فمثل المرأة المرددة بين الزوجه والاجنبية خارج عن محل الكلام، لان أصالة عدم علاقة الزوجية المقتضية للحرمة بل إستصحاب الحرمة حاكمة على أصالة الاباحة.ونحوها المال المردد بين مال نفسه وملك الغير مع سبق ملك الغير له.
وأما مع عدم سبق ملك أحد عليه، فلا ينبغي الاشكال في عدم ترتب أحكام ملكه عليه من جواز بيعه ونحوه مما يعتبر فيه تحقق المالية.
وأما إباحة التصرفات الغير المترتبة في الادلة على ماله وملكه فيمكن القول به للاصل.
ويمكن عدمه، لان الحلية في الاملاك لا بد لها من سبب محلل بالاستقراء، ولقوله عليه السلام: (لا يحل مال إلا من حيث أحله الله).
ومبنى الوجهين أن إباحة التصرف هي المحتاجة إلى السبب فيحرم مع عدمه ولو بالاصل وأن حرمة التصرف محمولة في الادلة على ملك الغير.فمع عدم تملك الغير ولو بالاصل ينتفي الحرمة.ومن قبيل ما لا يجري فيه أصالة الاباحة اللحم المردد بين المذكى والميتة.فإن أصالة عدم التذكية المقتضية للحرمة والنجاسة حاكمة على أصالة الاباحة والطهارة.
وربما يتخيل خلاف ذلك، تارة لعدم حجية إستصحاب عدم التذكية، وأخرى لمعارضة أصالة عدم التذكية بأصالة عدم الموت والحرمة والنجاسة من أحكام الميتة.
والاول مبني على عدم حجية الاستصحاب ولو في الامور العدمية.
والثاني مدفوع، أولا، بأنه يكفي في الحكم بالحرمة عدم التذكية ولو بالاصل، ولا يتوقف على
ثبوت الموت حتى ينتفي بإنتفائه ولو بحكم الاصل.
والدليل عليه إستثناء (ما ذكيتم) من قوله (و ما أكل السبع)، فلم يبح الشارع إلا ما ذكي، وإناطة إباحة الاكل بما ذكر اسم الله عليه وغيره من الامور الوجودية المعتبرة في التذكية.فإذا إنتفى بعضها ولو بحكم الاصل إنتفت الاباحة.
وثانيا، أن الميتة عبارة عن غير المذكى، إذ ليست الميتة خصوص ما مات حتف أنفه، بل كل زهاق روح إنتفى فيه شرط من شروط التذكية فهي ميتة شرعا.وتمام الكلام في (الفقه).
الثاني إن الشيخ الحر، قدس سره، أورد في بعض كلماته إعتراضا على معاشر الاخباريين.
وحاصله أنه ما الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريقه، حيث أوجبتم الاحتياط في الاول دون الثاني؟ وأجاب بما لفظه: (إن حد الشبهة في الحكم حكمه الشرعي، أعني الاباحة والتحريم.
و حد الشبهة في طريق الحكم الشرعي ما اشتبه فيه موضوع الحكم، كاللحم المشترى من السوق لا يعلم أنه مذكى أو ميتة، مع العلم لحكم المذكى والميتة.
ويستفاد هذا التقسيم من أحاديث ومن وجوه عقلية مؤيدة لتلك الاحاديث، ويأتي بعضها وقسم متردد بين القسمين، وهي الافراد التي ليست بظاهرة الفردية لبعض الانواع.
وليس إشتباهها بسبب شئ من الامور الدنيوية كإختلاط الحلال بالحرام، بل إشتباهها لامر ذاتى، أعني إشتباه صنفها في نفسها، كبعض أفراد الغناء الذى قد ثبت تحريم نوعه واشتبه أنواع في أفراد يسيرة، وبعض أفراد الخبائث الذى قد ثبت تحريم نوعه واشتبه بعض أفراده.حتى إختلف العقلاء فيها، ومنها شرب التتن.
وهذا النوع يظهر من الاخبار دخوله في الشبهات التي ورد الامر بإجتنابها.
وهذه التفاصيل يستفاد من مجموع الاحاديث، ونذكر مما يدل على ذلك وجوها: منها قوله عليه السلام: (كل شئ فيه حلال و حرام فهو لك حلال).
فهذا وأشباهه صادق على الشبهة في طريق الحكم - إلى أن قال - وإذا حصل الشك في تحريم الميتة لم يصدق عليها أن فيها حلالا ولا حراما).
أقول: كان مطلبه أن هذه الرواية وأمثالها مخصصة لعموم ما دل على وجوب التوقف والاحتياط
في مطلق الشبهة، وإلا فجريان أصالة الاباحة في الشبهة الموضوعية لا ينفي جريانها في الشبهة الحكمية.
مع أن سياق أخبار التوقف والاحتياط يأبى عن التخصيص من حيث إشتمالها على العلة العقلية لحسن التوقف والاحتياط، أعني الحذر من الوقوع في الحرام والهلكة.فحملها على الاستحباب أولى.
ثم قال: (ومنها: قوله " ص ": حلال بين وحرام بين وشبهات.
وهذا إنما ينطبق على الشبهة في نفس الحكم وإلا لم يكن الحلال البين ولا الحرام البين ولا يعلم أحدهما من الاخر إلا علام الغيوب.وهذا ظاهر واضح).
أقول: فيه - مضافا إلى ما ذكرنا من إباء سياق الخبر عن التخصيص - أن رواية التثليث التي هي العمدة من أدلتهم ظاهرة في حصر ما يبتلى به المكلف من الافعال في ثلاثة: فإن كانت عامة للشبهة الموضوعية أيضا صح الحصر، وإن إختصت بالشبهة الحكمية كان الفرد الخارجي المردد بين الحلال والحرام قسما رابعا، لانه ليس حلالا بينا ولا حراما بينا ولا مشتبه الحكم.
ولو استشهد بما قبل النبوي من قول الصادق عليه السلام: (إنما الامور ثلاثة)، كان ذلك أظهر في الاختصاص بالشبهة الحكمية، إذ المحصور في هذه الفقرة الامور التي يرجع فيها إلى بيان الشارع، فلا يرد إخلاله بكون الفرد الخارجي المشتبه أمرا رابعا للثلاثة.
وأما ما ذكره: (من المانع لشمول النبوي للشبهة الموضوعية من أنه لا يعلم الحلال من الحرام إلا علام الغيوب)، ففيه: أنه إن أريد عدم وجودهما، ففيه ما لا يخفى، وإن أريد ندرتهما، ففيه أن الندرة تمنع من إختصاص النبوي بالنادر لا من شمولها له، مع أن دعوى كون الحلال البين من حيث الحكم أكثر من الحلال البين من حيث الموضوع قابلة للمنع، بل المحرمات الخارجية المعلومة أكثر بمراتب من المحرمات الكلية المعلوم تحريمها.
ثم قال: (ومنها: ما ورد من الامر البليغ بإجتناب ما يحتمل الحرمة والاباحة بسبب تعارض الادلة وعدم النص.
وذلك واضح الدلالة على إشتباه نفس الحكم الشرعي).
أقول: ما دل على التخيير والتوسعة مع التعارض وعلى الاباحة مع عدم ورود النهي، وإن لم يكن في الكثرة بمقدار أدلة التوقف والاحتياط، إلا أن الانصاف أن دلالتها على الاباحة والرخصة أظهر من دلالة تلك الاخبار على وجوب الاجتناب.
قال: (ومنها: أن ذلك وجه للجمع بين الاخبار لا يكاد يوجد وجه أقرب منه).
أقول: مقتضى الانصاف أن حمل أدلة الاحتياط على الرجحان المطلق أقرب مما ذكره.
ثم قال: ما حاصله: (ومنها أن الشبهة في نفس الحكم يسئل عنها الامام، عليه السلام، بخلاف الشبهة في طريق الحكم، لعدم وجوب السؤال عنه، بل علمهم بجميع أفراده غير معلوم أو معلوم العدم، لانه من علم الغيب فلا يعلمه إلا الله وإن كانوا يعلمون منه ما يحتاجون إليه وإذا شاؤوا أن يعلموا شيئا علموه)، إنتهى.
أقول ما ذكره من الفرق لا مدخل له، فإن طريق الحكم لا يجب الفحص عنه وإزالة الشبهة فيه، لا من الامام عليه السلام ولا من غيره من الطرق المتمكن منها.
والرجوع إلى الامام عليه السلام إنما يجب فيما تعلق التكليف فيه بالواقع على وجه لا يعذر الجاهل المتمكن من العلم.
وأما مسألة مقدار معلومات الامام عليه السلام من حيث العموم والخصوص وكيفية علمه بها من حيث توقفه على مشيتهم أو على إلتفاتهم إلى نفس الشئ أو عدم توقف على ذلك، فلا يكاد يظهر من الاخبار المختلفة في ذلك ما يطمئن به النفس.فالاول وكول علم ذلك إليهم، صلوات الله عليهم أجمعين.
ثم قال: (ومنه: أن إجتناب الشبهة في نفس الحكم أمر ممكن مقدور، لان أنواعه محصورة، بخلاف الشبهة في طريق الحكم.
فإجتنابها غير ممكن، لما أشرنا إليه من عدم وجود الحلال البين ولزوم تكليف ما لا يطاق.
والاجتناب عما يزيد على قدر الضرورة حرج عظيم وعسر شديد، لاستلزامه الاقتصار في اليوم والليلة على لقمة واحدة وترك جميع الانتفاعات) إنتهى.
اقول: لا ريب أن أكثر الشبهات الموضوعية لا يخلو عن أمارات الحل والحرمة، كيد المسلم و السوق وأصالة الطهارة وقول المدعي بلا معارض والاصول العدمية المجمع عليها عند المجتهدين و الاخباريين على ما صرح به المحدث الاسترابادي، كما سيجئ نقل كلامه في الاستصحاب، و بالجملة فلا يلزم حرج من الاجتناب في الموارد الخالية عن هذه الامارات لقلتها.
قال: (ومنها: أن إجتناب الحرام واجب عقلا ونقلا، ولا يتم إلا بإجتناب ما يحتمل التحريم مما اشتبه حكمه الشرعي ومن الافراد الغير الظاهرة بالفردية، و ما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدورا فهو واجب، إلى غير ذلك من الوجوه.
وإن أمكن المناقشة في بعضها.
فمجموعها دليل كاف شاف في هذا المقام والله أعلم بحقائق الامور والاحكام)، إنتهى.
أقول: الدليل المذكور أولى بالدلالة على وجوب الاجتناب من الشبهة في طريق الحكم، بل لو تم لم يتم إلا فيه، لان وجوب الاجتناب عن الحرام لم يثبت إلا بدليل حرمة ذلك الشئ أو أمر وجوب إطاعة الاوامر والنواهي، مما ورد في الشرع وحكم به العقل.فهي كلها تابعة لتحقق الموضوع، أعني الامر والنهي.والمفروض الشك في تحقق النهي.
وحينئذ فإذا فرض عدم الدليل على الحرمة، فأين وجوب ذي المقدمة حتى يثبت وجوبها.
نعم يمكن أن يقال في الشبهة في طريق الحكم، بعدما قام الدليل على حرمة الخمر، يثبت وجوب الاجتناب عن جميع أفرادها الواقعية، ولا يحصل العلم بموافقة هذا الامر العام إلا بالاجتناب عن كل ما احتمل حرمته.
لكنك عرفت الجواب عنه سابقا، وأن التكليف بذي المقدمه غير محرز إلا بالعلم التفصيلي أو الاجمالي.
فالاجتناب عما يحتمل الحرمة إحتمالا مجردا عن العلم الاجمالي لا يجب لا نفسا ولا مقدمة، والله العالم.
الثالث: أنه لا شك في حكم العقل والنقل برجحان الاحتياط مطلقا، حتى فيما كان هناك أمارة على الحل مغنية عن أصالة الاباحة.
إلا أنه لا ريب في أن الاحتياط في الجميع موجب لاختلال النظام، كما ذكره المحدث المتقدم، بل يلزم أزيد مما ذكره فلا يجوز الامر به من الحكيم، لمنافاته للغرض و التبعيض بحسب الموارد.
وإستحباب الاحتياط حتى يلزم الاختلال أيضا مشكل، لان تحديده في غاية التعسر، فيحتمل التبعيض بحسب الاحتمالات، فيحتاط في المظنونات.
وأما المشكوكات فضلا عن إنضمام الموهومات إليها، فالاحتياط فيها حرج مخل بالنظام.
و يدل على هذا العقل بعد ملاحظه حسن الاحتياط مطلقا وإستلزام كليته الاختلال ويحتمل
التبعيض بحسب المحتملات.
فالحرام المحتمل إذا كان من الامور المهمة في نظر الشارع، كالدماء و الفروج، بل مطلق حقوق الناس بالنسبة إلى حقوق الله تعالى يحتاط فيه وإلا فلا.
ويدل على هذا جميع ما ورد من التأكيد في أمر النكاح، وأن شديد، وأنه يكون منه الولد.
منها: ما تقدم من قوله عليه السلام: (لا تجامعوا على النكاح بالشبهة) قال عليه السلام: (فإذا بلغك إمرأة أرضعتك - إلى أن قال -: إن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة).
وقد تعارض هذه بما دل على عدم وجوب السؤال والتوبيخ عليه وعدم قبول قول من يدعي حرمة المعقودة مطلقا أو بشرط عدم كونه ثقة، وغير ذلك.
وفيه: أن مساقها التسهيل وعدم وجوب الاحتياط فلا ينافي الاستحباب، ويحتمل التبعيض بين مورد الامارة على الاباحة ومورد لا يوجد إلا أصالة الاباحة.
فيحمل ما ورد من الاجتناب عن الشبهات والوقوف عند الشبهات على الثاني دون الاول، لعدم صدق الشبهة بعد الامارة الشرعية على الاباحة.
فإن الامارات في الموضوعات بمنزلة الادلة في الاحكام مزيلة للشبهة ن خصوصا إذا كان المراد من الشبهة ما يتحير في حكمه، ولا بيان من الشارع لا عموما ولا خصوصا بالنسبة إليه، دون مطلق ما فيه الاحتمال.
وهذا بخلاف أصالة الاباحة، فإنها حكم في مورد الشبهة لا مزيلة لها، هذا.
ولكن أدلة الاحتياط لا تنحصر في ما ذكر فيه لفظ الشبهة، بل العقل مستقل بحسن الاحتياط مطلقا.
فالاولى الحكم برجحان الاحتياط في كل موضع لا يلزم منه الحرام.
وما ذكر من أن تحديد الاستحباب بصورة لزوم الاختلال عسر، فهو إنما يقدح في وجوب الاحتياط لا في حسنه.
الرابع: إباحة ما يحتمل الحرمة غير مختصة بالعاجز عن الاستعلالم، بل تشمل القادر على تحصيل العلم بالواقع.
لعموم أدلته من العقل والنقل.
وقوله، عليه السلام، في ذيل رواية مسعدة بن صدقة: (والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غيره أو تقوم به البينة)، فإن ظاهره حصول الاستبانة و قيام البينة لا بالتحصيل.
وقوله (هو لك حلال حتى يجيئك شاهدان).
لكن هذا وأشباهه، مثل قوله عليه السلام في اللحم المشترى من السوق (كل ولا تسأل)، وقوله عليه السلام: (ليس عليكم المسألة، إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم)، وقوله عليه السلام في حكاية المنقطعة التي تبين لها زوج: (لم سألت) واردة في موارد وجود الامارة الشرعية على الحلية، فلا يشمل ما نحن فيه، إلا أن المسألة غير خلافية مع كفاية الاطلاقات.
المطلب الثاني في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة من الاحكام
وفيه أيضا مسائل:
المسألة الاولى: فيما إشتبه حكمه الشرعي الكلي من جهة عدم النص المعتبر كما إذا ورد خبر ضعيف أو فتوى جماعة بوجوب فعل، كالدعاء عند رؤية الهلال، وكالاستهلال في رمضان وغير ذلك.
المعروف من الاخباريين هنا موافقة المجتهدين في العمل بأصالة البراءة و عدم وجوب الاحتياط.
قال المحدث الحر العاملي في باب القضاء من الوسائل (إنه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشك في الوجوب إلا إذا علمنا إشتغال الذمة بعبارة معينة وحصل الشك بين الفردين، كالقصر والاتمام والظهر والجمعة وجزاء واحد للصيد أو إثنين ونحو ذلك، فإنه يجب الجمع بين العبادتين، لتحريم تركهما معا للنص وتحريم الجزم بوجوب أحدهما بعينه عملا بأحاديث الاحتياط)، إنتهى موضع الحاجة.
وقال المحدث البحراني في مقدمات كتابه، بعد تقسيم أصل البراءة إلى قسمين: (أحدهما أنها عبارة عن نفي وجوب فعل وجودي، بمعنى أن الاصل عدم الوجوب حتى يقوم دليل على الوجوب.
وهذا القسم لا خلاف في صحة الاستدلال به، إذ لم يقل أحد: إن الاصل الوجوب).
وقال في محكي كتابه المسمى بالدرر النجفية: (إن كان الحكم المشكوك دليله هو الوجوب فلا خلاف ولا إشكال في إنتفائه حتى يظهر دليل لاستلزام التكليف بدون دليل الحرج والتكليف بما لا يطاق)، إنتهى.
لكنه، رحمه الله، في مسألة وجوب الاحتياط قال بعد القطع برجحان الاحتياط: (إن منه ما يكون واجبا ومنه ما يكون مستحبا.
فالاول كما إذا تردد المكلف في الحكم، إما لتعارض الادلة، أو لتشابهها وعدم وضوح دلالتها، أو لعدم الدليل بالكلية، بناء على نفي البراءة الاصلية، أو لكون ذلك الفرد مشكوكا في إندارجه تحت بعض الكليات المعلومة الحكم أو نحو ذلك.
والثاني كما إذا حصل الشك بإحتمال وجود النقيض لما قام عليه الدليل الشرعي إحتمالا مستندا إلى بعض الاسباب المجوزة.
كما إذا كان مقتضى الدليل الشرعي إباحة شئ وحليته.لكن يحتمل قريبا بسبب بعض تلك الاسباب أنه مما حرمه الشارع.ومنه جوائز الجائر ونكاح إمرأة بلغك أنها أرتضعت معك الرضاع المحرم ولم يثبت شرعا.
ومنه أيضا الدليل المرجوح في نظر الفقيه.
أما إذا لم يحصل ما يوجب الشك والريبة، فإنه يعمل على ما ظهر له من الادلة وإن احتمل النقيض في الواقع ولا يستحب له الاحتياط، بل ربما كان مرجوحا لاستفاضة الاخبار بالنهي عن السؤال عند الشراء من سوق المسلمين).
ثم ذكر الامثلة للاقسام الثلاثة لوجوب الاحتياط، أعني إشتباه الدليل وتردده بين الوجوب والاستحباب وتعارض الدليين وعدم النص قال: (ومن هذا القسم ما لم يرد فيه نص من الاحكام التي لا يعم به البلوى عند من لم يعتمد على البراءة الاصلية، فإن الحكم فيه ما ذكرنا، كما سلف)، إنتهى.
وممن يظهر منه وجوب الاحتياط هنا المحدث الاسترابادي، حيث حكى عنه في الفوائد المدنية أنه قال: (إن التمسك بالبراءة الاصلية إنما يجوز قبل إكمال الدين.
وأما بعد تواتر الاخبار بأن كل واقعة محتاج إليها فيها خطاب قطعي من قبل الله تعالى فلا يجوز قطعا.
وكيف يجوز وقد تواتر عنهم، عليهم السلام، وجوب التوقف في ما لم يعلم حكمها معللين بأنه بعد أن كملت الشريعه لا تخلو واقعة عن حكم قطعي وارد من
الله تعالى.ومن حكم بغير ما أنزل الله تعالى فأولئك هم الكافرون).
ثم اقول: هذا المقام مما زلت فيه أقدام أقوام من فحول العلماء.
فحري بنا أن نحقق المقام ونوضحه بتوفيق الملك العلام ودلالة أهل الذكر عليهم السلام.
فنقول: التمسك بالبراءة الاصلية إنما يتم عند الاشاعرة المنكرين للحسن والقبح الذاتيين.
وكذلك عند من يقول بهما ولا يقول بالحرمة والوجوب الذاتيين، كما هو المستفاد من كلامهم عليهم السلام، وهو الحق عندي.
ثم على هذين المذهبين إنما يتم قبل إكمال الدين لا بعده إلا على مذهب من جوز من العامة خلو الواقعة عن الحكم.
لا يقال: بقي هنا أصل آخر، وهو أن يكون الخطاب الوارد في الواقعة موافقا للبراءة الاصلية.
لانا نقول: هذا الكلام مما لا يرضى له لبيب، لان خطابه تعالى تابع للمصالح والحكم، ومقتضيات الحكم والمصالح مختلفة - إلى أن قال: - هذا الكلام مما لا يرتاب في قبحه.
نظير أن يقال: الاصل في الاجسام تساوي نسبة طبايعها إلى جهة السفل والعلو، ومن المعلوم بطلان هذا المقال.
ثم أقول: هذا الحديث المتواتر بين الفريقين المشتمل على حصر الامور في الثلاثة وحديث (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)، ونظائرهما، أخرج كل واقعة لم يكن حكمها مبينا من البراءة الاصلية وأوجب التوقف فيها.
ثم قال: بعد أن الاحتياط قد يكون في محتمل الوجوب وقد يكون في محتمل الحرمة: (إن عادة العامة والمتأخرين من الخاصة جرت بالتمسك بالبراءة الاصلية.
ولما أبطلنا جواز التمسك بها في المقامين، لعلمنا بأن الله تعالى أكمل لنا ديننا و علمنا بأن كل واقعة يحتاج إليها ورد فيها خطاب قطعي من الله تعالى خال عن المعارض، وبأن كل ما جاء به نبينا " ص " مخزون عند العترة الطاهرة، ولم يرخصوا لنا في التمسك بالبراءة الاصلية، بل أوجبوا التوقف في كل ما لم يعلم حكمه، وأوجبوا الاحتياط في بعض صوره، فعلينا أن نبين ما يجب أن يفعل في
المقامين، وسنحققه فيما يأتي إن شاء الله تعالى.
وذكر هناك ما حاصله: (وجوب الاحتياط عند تساوي إحتمال الامر الوارد بين الوجوب والاستحباب ولو كان ظاهرا في الندب بني على جواز الترك.وكذا لو وردت رواية ضعيفة بوجوب شئ وتمسك في ذلك بحديث: ما حجب الله علمه، وحديث رفع التسعة.
قال: وخرج عن تحتهما كل فعل وجودي لم يقطع بجوازه لحديث التثليث).
أقول: قد عرفت فيما تقدم في نقل كلام المحقق ره، أن التمسك بأصل البراءة منوط بدليل عقلي هو قبح التكليف بما لا طريق إلى العلم به.
وهذا لا دخل فيه لاكمال الدين وعدمه، و لكون الحسن والقبح أو الوجوب والتحريم عقليين أو شرعيين في ذلك.
والعمدة فيما ذكره هذا المحدث من أوله إلى آخره تخيله أن مذهب المجتهدين التمسك بالبراءة الاصلية لنفي الحكم الواقعي ولم أجد أحدا يستدل بها على ذلك.
نعم قد عرفت سابقا أن ظاهر جماعة من الامامية جعل أصل البراءة من الادلة الظنية، كما تقدم في المطلب الاول إستظهار ذلك من صاحبي المعالم والزبدة.
لكن ما ذكره من إكمال الدين لا ينفي حصول الظن، بجواز دعوى أن المظنون بالاستصحاب أو غيره موافقة ما جاء به النبي " ص " للبراءة.
وما ذكره من تبعية خطاب الله تعالى للحكم و المصالح لا ينافي ذلك.
لكن الانصاف: أن الاستصحاب لا يفيد الظن خصوصا في المقام، كما سيجئ إن شاء الله تعالى، في محله ولا أمارة غيره يفيد الظن.
فالاعتراض على مثل هؤلاء إنما هو منع حصول الظن و منع إعتباره على تقدير الحصول.
ولا دخل لاكمال الدين وعدمه، ولا للحسن والقبح العقليين في هذا المنع.
وكيف كان فيظهر من المعارج القول بالاحتياط في المقام عن جماعة حيث قال: (الاحتياط غير لازم.
وصار آخرون إلى لزومه وفصل أخرون)، إنتهى.وحكى عن المعالم نسبته إلى جماعة.
فالظاهر أن المسألة خلافية، لكن لم يعرف القائل به بعينه.
وإن كان يظهر من الشيخ و السيدين، رحمهم الله، التمسك به أحيانا، لكن يعلم مذهبهم من أكثر المسائل.
والاقوى فيه جريان أصالة البراءة للادلة الاربعة المتقدمة مضافا إلى الاجماع المركب.
وينبغي التنبيه على أمور الاول: أن محل الكلام في هذه المسألة هو احتمال الوجوب النفسي المسقتل.
وأما إذا احتمل كون شئ واجبا لكونه جزء وشرطا لواجب آخر، فهو داخل في الشك في المكلف به، وإن كان المختار جريان أصل البراءة فيه أيضا، كما سيجئ إن شاء الله تعالى، لكنه خارج عن هذه المسألة الاتفاقية.
الثاني: إنه لا إشكال في رجحان الاحتياط بالفعل حتى فيما احتمل كراهته.
والظاهر ترتب الثواب عليه إذا اتي به لداعي إحتمال المحبوبية، لانه إنقياد وإطاعة حكمية.
والحكم بالثواب هنا أولى من الحكم بالعقاب على تارك الاحتياط اللازم، بناء على أنها في حكم المعصية وإن لم يفعل محرما واقعيا.
وفي جريان ذلك في العبادات عند دوران الامر بين الوجوب وغير الاستحباب وجهان، أقواهما العدم، لان العبادة لا بد فيها من نية التقرب المتوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو إجمالا كما في كل من الصلوات الاربع عند إشتباه القبلة.
وما ذكرنا من ترتب الثواب على هذا الفعل لا يوجب تعلق الامر به، بل هو لاجل كونه إنقيادا للشارع، والعبد معه في حكم المطيع، بل لا يسمى ذلك ثوابا.
ودعوى: (أن العقل إذا إستقل بحسن هذا الاتيان ثبت بحكم الملازمة الامر به شرعا)، مدفوعة، بما تقدم في المطلب الاول، من أن الامر الشرعي بهذا النحو من الانقياد كأمره بالانقياد الحقيقي والاطاعة الواقعية في معلوم التكليف إرشادي محض، لا يترتب على موافقته ومخالفته أزيد
مما يترتب على نفس وجود المأمور به أو عدمه، كما هو شأن الاوامر الارشادية، فلا إطاعة لهذا الامر الارشادي، ولا ينفع في جعل الشئ عبادة.
كما أن إطاعة الاوامر المتحققة لم تصر عبادة بسبب الامر الوارد بها في قوله تعالى: (أطيعوا الله ورسوله).
ويحتمل الجريان بناء على أن هذا المقدار من الحسن العقلي يكفي في العبادة ومنع توقفها على ورود أمر بها يكفي الاتيان به لاحتمال كونه مطلوبا أو كون تركه مبغوضا.
ولذا إستقرت سيرة العلماء والصلحاء فتوى وعملا على إعادة العبادات لمجرد الخروج عن مخالفة النصوص الغير المعتبرة والفتاوى النادرة.
واستدل في الذكرى، في خاتمة قضاء الفوائت، على شرعية قضاء الصلاة لمجرد إحتمال خلل فيها موهوم بقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم)، و (اتقوا الله حق تقاته)، وقوله: (واللذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون).
والتحقيق: أنه إن قلنا بكفاية إحتمال المطلوبية في صحة العبادة فيما لا يعلم المطلوبيه ولو إجمالا فهو، وإلا فما أورده، رحمه الله، في الذكرى، كأوامر الاحتياط، لا يجدي في صحتها.
لان موضوع التقوى والاحتياط الذي يتوقف عليه هذه الاوامر لا يتحقق إلا بعد إتيان محتمل العبادة على وجه يجتمع فيه جميع ما يعتبر في العبادة حتى نية التقرب،وإلا لم يكن إحتياطا، فلا يجوز أن يكون تلك الاوامر منشا للقربة المنوية فيها.
اللهم إلا أن يقال - بعد النقض بورود هذا الايراد في الاوامر الواقعية بالعبادات.
مثل قوله: (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)، حيث أن قصد القربة مما يعتبر في موضوع العبادة شطرا أو شرطا.
والمفروض ثبوت مشروعيتها بهذا الامر الوارد فيها - إن المراد من الاحتياط والاتقاء في هذه الاوامر هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نية القربة.فمعنى الاحتياط بالصلاة الاتيان بجميع ما يعتبر فيها عدا قصد القربه.فأوامر الاحتياط تتعلق بهذا الفعل.وحينئذ فيقصد المكلف فيه التقرب بإطاعة هذا الامر.
ومن هنا يتجه الفتوى بإستحباب هذا الفعل، وإن لم يعلم المقلد كون هذا الفعل مما شك في كونها عبادة ولم يأت به بداعي إحتمال المطلوبية.
ولو أريد بالاحتياط في هذه الاوامر معناه الحقيقي، وهو إتيان الفعل لداعي إحتمال المطلوبية لم يجز للمجتهد أن يفتي بإستحبابه مع التقييد بإتيانه بداعي الاحتمال حتى يصدق عليه عنوان
الاحتياط مع إستقرار سيرة أهل الفتوى على خلافه.فيعلم أن المقصود إتيان الفعل بجميع ما يعتبر فيه عدا نية الداعي.
ثم إن منشأ إحتمال الوجوب، إذا كان خبرا ضعيفا، فلا حاجة إلى أخبار الاحتياط وكلفه إثبات أن الامر فيها للاستحباب الشرعي دون الارشاد العقلي، لورود بعض الاخبار بإستحباب فعل كل ما يحتمل فيه الثواب.
كصحيحة هشام بن سالم المحكية عن المحاسن عن ابي عبدالله عليه السلام.
قال: (من بلغه عن النبي، صلى الله عليه وآله، شئ من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله " ص " لم يقله).
وعن البحار، بعد ذكرها: (أن هذا الخبر من المشهورات رواه العامة والخاصة بأسانيد).
والظاهر أن المراد من (شئ من الثواب) بقرينة ضمير (فعمله) وإضافة الاجر إليه هو الفعل المشتمل على الثواب.
وفي عدة الداعي عن الكليني، رحمه الله، أني روى بطرقه عن الائمة عليهم السلام: (انه من بلغه شئ من الخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه وإن لم يكن كما بلغه).
وأرسل نحوه السيد، رحمه الله، في الاقبال عن الصادق عليه السلام.
إلا أن فيه: (كان له ذلك.
والاخبار الواردة في هذا الباب كثيرة، إلا أن ما ذكرناه أوضح دلالة على ما نحن فيه.
وإن كان يورد عليه أيضا، تارة بأن ثبوت الاجر لا يدل على الاستحباب الشرعي، وأخرى بما تقدم من أوامر الاحتياط من أن قصد القربة مأخوذ في الفعل المأمور به بهذه الاخبار، فلا يجوز أن تكون هي المصححة لفعله فيختص موردها بصورة تحقق الاستحباب وكون البالغ هو الثواب الخاص فهو المتسامح فيه دون أصل شرعية الفعل.
وثالثة بظهورها فيما بلغ فيه الثواب المحض لا العقاب محضا او مع الثواب.
لكن يرد هذا منع الظهور مع إطلاق الخبر، ويرد ما قبله ما تقدم في أوامر الاحتياط.
وأما الايراد الاول، فالانصاف أنه لا يخلو عن وجه، لان الظاهر من هذه الاخبار كون العمل
متفرعا على البلوغ وكونه الداعي على العمل.
ويؤيده تقييد العمل في غير واحد من تلك الاخبار بطلب قول النبي " ص " وإلتماس الثواب الموعود.
ومن المعلوم أن العقل مستقل بإستحقاق هذا العامل المدح والثواب.
وحينئذ فإن كان الثابت بهذا الاخبار أصل الثواب كانت مؤكده لحكم العقل بالاستحقاق.
وأما طلب الشارع لهذا الفعل: فإن كان على وجه الارشاد لاجل تحصيل هذا الثواب الموعود فهو لازم للاستحقاق المذكور وهو عين الامر بالاحتياط.
وإن كان على وجه الطلب الشرعي المعبر عنه بالاستحباب فهو غير لازم للحكم بتنجز الثواب، لان هذا الحكم تصديق لحكم العقل بتنجزه فيشبه قوله تعالى: (ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري)، إلا أن هذا وعد على الاطاعة الحقيقية.
وما نحن فيه وعد على الاطاعة الحكمية، وهو الفعل الذي يعد معه العبد في حكم المطيع.
فهو من باب وعد الثواب على نية الخير التي يعد معها العبد في حكم المطيع من حيث الانقياد.
وأما ما يتوهم من: (ان إستفادة الاستحباب الشرعي فيما نحن فيه.
نظير إستفادة الاستحباب الشرعي من الاخبار الواردة في الموارد الكثيرة المقتصر فيها على ذكر الثواب للعمل، مثل قوله عليه السلام: (من سرح لحيته فله كذا)، مدفوع: بأن الاستفادة هناك بإعتبار أن ترتب الثواب لا يكون إلا مع الاطاعة حقيقة أو حكما.
فمرجع تلك الاخبار إلى بيان الثواب على إطاعة الله سبحانه بهذا الفعل، فهي تكشف عن تعلق الامر بها من الشارع.
فالثواب هناك لازم للامر يستدل به عليه إستدلالا إنيا.
ومثل ذلك إستفادة الوجوب والتحريم مما اقتصر فيه على ذكر العقاب على الترك أو الفعل.
وأما الثواب الموعود في هذه الاخبار فهو بإعتبار الاطاعة الحكمية، فهو لازم لنفس عمله المتفرع على السماع و إحتمال الصدق ولو لم يرد به أمر آخر أصلا، فلا يدل على طلب شرعي آخر له.
نعم يلزم من الوعد على الثواب طلب إرشادي لتحصيل ذلك الموعود.
فالغرض من هذه الاوامر، كأوامر الاحتياط، تأييد حكم العقل والترغيب في تحصيل ما وعد الله عباده المنقادين المعدودين بمنزلة المطيعين.
وإن كان الثابت بهذه الاخبار خصوص الثواب البالغ كما هو ظاهر بعضها فهو، وإن كان مغايرا لحكم العقل بإستحقاق أصل الثواب على هذا العمل، بناء على أن العقل لا يحكم بإستحقاق ذلك الثواب المسموع الداعي إلى الفعل، بل قد يناقش في تسمية ما يستحقه هذا العامل لمجرد إحتمال الامر ثوابا وإن كان نوعا من الجزاء والعوض، إلا أن مدلول هذا الاخبار إخبار عن تفضل
الله سبحانه على العامل بالثواب المسموع.
وهو أيضا ليس لازما لامر شرعي هو الموجب لهذا الثواب، بل هو نظير قوله تعالى: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها)، ملزوم لامر إرشادي يستقل به العقل بتحصيل ذلك الثواب المضاعف.
والحاصل أنه كان ينبغي للمتوهم أن يقيس ما نحن فيه بما ورد من الثواب على نية الخير، لا على ما ورد من الثواب في بيان المستحبات.
ثم إن الثمرة بين ما ذكرنا وبين الاستحباب الشرعي تظهر في ترتب الاثار الشرعية المترتبة على المستحبات الشرعية، مثل إرتفاع الحدث المترتب على الوضوء المأمور به شرعا، فإن مجرد ورود خبر غير معتبر بالامر به لا يوجب إلا إستحقاق الثواب عليه ولا يترتب عليه رفع الحدث، فتأمل، وكذا الحكم بإستحباب غسل المسترسل من اللحية في الوضوء من باب مجرد الاحتياط لا يسوغ جواز المسح ببلله، بل يحتمل قويا أن يمنع من المسح من بلله وإن قلنا بصيرورته مستحبا شرعيا، فافهم.
الثالث: أن الظاهر إختصاص أدلة البراءه بصورة الشك في الوجوب التعييني، سواء كان أصليا أو عرضيا، كالواجب المخير المتعين لاجل الانحصار.
أما لو شك في الوجوب التخييري والاباحة فلا تجري فيه أدلة البراءه، لظهورها في عدم تعيين المجهول على المكلف بحيث يلزم به ويعاقب عليه.
وفي جريان أصالة عدم الوجوب تفصيل، لانه إن كان الشك في وجوبه في ضمن كلي مشترك بينه وبين غيره أو وجوب ذلك الغير بالخصوص، فيشكل جريان أصالة عدم الوجوب، إذ ليس هنا إلا وجوب واحد متردد بين الكلي والفرد، فتعين هنا أصالة إجراء عدم سقوط ذلك الفرد المتيقن الوجوب بفعل هذا المشكوك، وأما إذا كان الشك في إيجابه بالخصوص جرى أصالة عدم الوجوب وأصالة عدم لازمه الوضعي، وهو سقوط الواجب المعلوم إذا شك في إسقاطه له.
أما إذا قطع بكونه مسقطا للوجوب المعلوم، وشك في كونه واجبا مسقطا للواجب الاخر أو مباحا مسقطا لوجوبه، نظير السفر المباح المسقط لوجوب الصوم، فلا مجرى للاصل إلا بالنسبة إلى طلبه و تجري أصالة البراءه عن وجوبه التعيينى بالعرض إذا فرض تعذر بتعذر ذلك الواجب الاخر.
وربما يتخيل من هذا القبيل ما لو شك في وجوب الايتمام على من عجز عن القراءة وتعلمها، بناء على رجوع المسألة إلى الشك في كون الايتمام مستحبا مسقطا أو واجبا مخيرا بينه وبين الصلاة مع القراءة.
فيدفع وجوبه التخييري بالاصل.
لكن الظاهر أن المسألة ليست من هذا القبيل، لان صلاة الجماعة فرد من الصلاة الواجبة، فتتصف بالوجوب لا محالة، وإتصافها بالاستحباب من باب أفضل فردي الواجب، فيختص بما إذا تمكن المكلف من غيره.
فإذا عجز تعين وخرج عن الاستحباب.
كما إذا منعه مانع آخر عن الصلاة منفردا، لكن يمكن منع تحقق العجز فيما نحن فيه، فإنه يتمكن من الصلاة منفردا بلا قراءة، لسقوطها عنه بالتعذر، كسقوطها بالايتمام.فتعين أحد المسقطين يحتاج إلى دليل.
قال فخر المحققين في الايضاح في شرح قول والده رحمه الله: (والاقرب وجوب الايتمام على الامي العاجز): ووجه القرب تمكنه من صلاة صحيحة القراءة.
و يحتمل عدمه، لعموم نصين: أحدهما الاكتفاء بما يحسن مع عدم التمكن من التعليم، والثاني ندبية الجماعة.
والاول أقوى، لانه يقوم مقام القراءة إختيارا فيتعين عند الضرورة، لان كل بدل إختياري يجب عينا عند تعذر مبدله، وقد بين ذلك في الاصول.ويحتمل العدم، لان قراءة الامام مسقطة لوجوب القراءة على المأموم.و التعذر أيضا مسقط.
فإذا وجد أحد المسقطين للوجوب لم يجب الاخر، إذ التقدير أن كلا منهما سبب تام والمنشأ أن قراءة الامام بدل أو مسقط)، إنتهى.
والمسأله محتاجة إلى التأمل.
ثم إن الكلام في الشك في الوجوب الكفائي، كوجوب رد السلام على المصلي إذا سلم على جماعة وهو منهم، يظهر مما ذكرنا، فافهم.
المسألة الثانية: فيما إشتبه حكمه الشرعي من جهة إجمال اللفظ كما إذا قلنا بإشتراك لفظ الامر بين الوجوب والاستحباب أو الاباحة.والمعروف هنا عدم وجوب الاحتياط.
وقد تقدم عن المحدث العاملي في الوسائل أنه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشك في الوجوب ويشمله أيضا معقد إجماع المعارج.
لكن تقدم من المعارج أيضا عند ذكر الخلاف في وجوب الاحتياط وجود القائل بوجوبه هنا.
وقد صرح صاحب الحدائق تبعا للمحدث الاسترابادي بوجوب التوقف والاحتياط هنا في الحدائق، بعد ذكر وجوب التوقف: (إن من يعتمد على اصالة البراءة يجعلها هنا مرجحة للاستحباب.
وفيه: أولا منع جواز الاعتماد على البرائة الاصليه في الاحكام الشرعية.
وثانيا أن مرجع ذلك إلى أن الله تعالى حكم بالاستحباب لموافقة البراءة.
ومن المعلوم أن أحكام الله تعالى تابعة للمصالح والحكم الخفية.
ولا يمكن أن يقال: إن مقتضى المصلحة موافقة البراءه الاصلية، فإنه رجم بالغيب وجرءة بلا ريب)، إنتهى.
وفيه ما لا يخفى، فإن القائل بالبراءة الاصلية إن رجع إليها من باب حكم العقل بقبح العقاب من دون البيان فلا يرجع ذلك إلى دعوى كون حكم الله هو الاستحباب، فضلا عن تعليل ذلك بالبراءة الاصلية، وإن رجع إليها بدعوى حصول الظن فحديث تبعية الاحكام للمصالح وعدم تبعيتها، كما عليه الاشاعره، أجنبي عن ذلك، إذ الواجب عليه إقامة الدليل على إعتبار هذا الظن المتعلق بحكم الله الواقعي الصادر عن المصلحة أولا عنها على الخلاف.
وبالجملة، فلا أدري وجها للفرق بين ما لا نص فيه وبين ما أجمل فيه النص، سواء قلنا بإعتبار
هذا الاصل من باب حكم العقل أو من باب الظن، حتى لو جعل مناط الظن عموم البلوى، فإن عموم البلوى فيما نحن فيه يوجب الظن بعدم قرينة الوجوب مع الكلام المجمل المذكور وإلا لنقل مع توقر الدواعي، بخلاف الاستحباب، لعدم توفر الدواعي على نقله.ثم إن ما ذكرنا من حسن الاحتياط جار هنا.والكلام في إستحبابه شرعا كما تقدم.
نعم الاخبار المتقدمة فيمن بلغه الثواب لا يجري هنا، لان الامر لو دار بين الوجوب والاباحة لم يدخل في مواردها، لان المفروض إحتمال الاباحة، فلا يعلم بلوغ الثواب.
وكذا لو دار بين الوجوب والكراهة ولو دار بين الوجوب و الاستحباب لم يحتج إليها، والله العالم.
المسألة الثالثة: فيما إشتبه حكمه الشرعي من جهة تعارض النصين وهنا مقامات، لكن المقصود هنا إثبات عدم و جوب التوقف والاحتياط.والمعروف عدم وجوبه هنا.وما تقدم في المسأله الثانية من نقل الوفاق والخلاف آت هنا.
وقد صرح المحدثان المتقدمان لوجوب التوقف والاحتياط هنا.
ولا مدرك له سوى أخبار التوقف التي قد عرفت ما فيها من قصور الدلالة على الوجوب فيما نحن فيه، مع أنها أعم مما دل على التوسعة و التخيير.
وما دل على التوقف في خصوص المتعارضين وعدم العمل بواحد منها مختص أيضا بصورة التمكن من إزالة الشبهة بالرجوع إلى الامام عليه السلام.
وأما رواية عوالي اللئالي المتقدمة الامرة بالاحتياط وإن كانت أخص منها إلا أنك قد عرفت ما فيها مع إمكان حملها على صورة التمكن من الاستعلام.
ومنه يظهر عدم جواز التمسك بصحيحة إبن الحجاج الواردة في جزاء الصيد، بناء على إستظهار شمولها بإعتبار المناط لما نحن فيه.
ومما يدل على الامر بالتخيير، في خصوص ما نحن فيه من إشتباه الوجوب بغير الحرمة، التوقيع المروي في الاحتجاج عن الحميري، حيث كتب إلى الصاحب عجل الله فرجه: سألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الاول إلى الركعة الثالثة، هل يجب عليه أن يكبر، فإن بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه تكبيرة ويجوز أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد.
الجواب: في ذلك حديثان.
أما أحدهما، فإنه إذا إنتقل عن حالة إلى أخرى فعليه التكبير.
وأما الحديث الاخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر، ثم جلس، ثم قام، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، والتشهد الاول
يجري هذا المجرى، وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا)، الخبر.
فإن الحديث الثاني وإن كان أخص من الاول وكان اللازم تخصيص الاول به والحكم بعدم وجوب التكبير، إلا أن جوابه، صلوات الله عليه وعلى آبائه، بالاخذ بأحد الحديثين من باب التسليم يدل على أن الحديث الاول نقله الامام، عليه السلام، بالمعنى وأراد شموله لحالة الانتقال من القعود إلى القيام بحيث لا يتمكن إرادة ما عدا هذا الفرد منه، فأجاب عليه السلام بالتخيير.
ثم: إن وظيفة الامام وإن كانت إزالة الشبهة عن الحكم الواقعي إلا أن هذا الجواب لعله تعليم طريق العمل عند التعارض مع عدم وجوب التكبير عنده في الواقع وليس فيه الاغراء بالجهل من حيث قصد الوجوب فيما ليس بواجب من جهة كفاية قصد القربة في العمل.
وكيف كان فإذا ثبت التخيير بين دليلي وجوب الشئ على وجه الجزئيه وعدمه يثبت فيما نحن فيه من تعارض الخبرين في ثبوت التكليف المستقل بالاجماع والاولوية القطعية.
ثم إن جماعة من الاصوليين ذكروا في باب التراجح الخلاف في ترجيح الناقل أو المقرر، و حكي عن الاكثر ترجيح الناقل وذكروا تعارض الخبر المفيد للوجوب والمفيد للاباحة.
وذهب جماعة إلى ترجيح الاول وذكروا تعارض الخبر المفيد للاباحة والمفيد للحظر، وحكي عن الاكثر، بل الكل، تقديم الحاظر، ولعل هذا كله مع قطع النظر عن الاخبار.
المسألة الرابعة: دوران الامر بين الوجوب وغيره من جهة الاشتباه في موضوع الحكم ويدل عليه جميع ما تقدم في الشبهة الموضوعية التحريه من أدلة البراءة عند الشك في التكليف، وتقدم فيها أيضا إندفاع توهم أن التكليف إذا تعلق بمفهوم وجب مقدمة لامتثال التكليف في جميع أفراده موافقته في كل ما يحتمل أن يكون فردا له، ومن ذلك يعلم أنه لا وجه للاستناد إلى قاعدة الاشتغال فيما إذا ترددت الفائتة بين الاقل والاكثر، كصلاتين وصلاة واحدة، بناء على أن الامر بقضاء جميع ما فات واقعا يقتضي لزوم الاتيان بالاكثر من باب المقدمة.
توضيح ذلك، مضافا إلى ما تقدم في الشبهة التحريمية، أن قوله: (إقض ما فات)، يوجب العلم التفصيلي بوجوب قضاء ما علم فوته، وهو الاقل، ولا يدل أصلا على وجوب ما شك في فوته وليس فعله مقدمة لواجب حتى يجب من باب المقدمة.
فالامر بقضاء ما فات واقعا لا يقتضي إلا وجوب المعلوم فواته، لا من جهة دلالة اللفظ على المعلوم حتى يقال إن اللفظ ناظر إلى الواقع من غير تقييد بالعلم به بل من جهة أن الامر بقضاء الفائت الواقعي لا يعد دليلا إلا على ما علم صدق الفائت عليه.وهذا لا يحتاج إلى مقدمة ولا يعلم منه وجوب شئ آخر يحتاج إلى المقدمة العلمية.
والحاصل: أن المقدمه العلمية المتصفة بالوجوب لا يكون إلا مع العلم الاجمالي.
نعم لو أجري في المقام أصالة عدم الاتيان بالفعل في الوقت فيجب قضاؤه فله وجه، وسيجئ الكلام عليه.
هذا.
ولكن المشهور بين الاصحاب، رضوان الله عليهم بل المقطوع به من المفيد قدس سره إلى الشهيد الثانى أنه لو لم يعلم كمية ما فات حتى يظن الفراغ بها.
وظاهر ذلك، خصوصا بملاحظة ما يظهر من إستدلال بعضهم من كون الاكتفاء بالظن رخصة وأن القاعدة تقتضي وجوب العلم بالفراغ، كون الحكم على القاعده.
قال في التذكرة:
(لو فاتته صلوات معلومة العين غير معلومة العدد صلى من تلك الصلوات إلى أن يغلب في ظنه الوفاء لاشتغال الذمة بالفائت، فلا يحصل البراءة قطعا إلا بذلك.
ولو كانت واحدة ولم يعلم العدد صلى تلك الصلاة مكررا حتى يظن الوفاء.
ثم احتمل في المسألة إحتمالين آخرين: أحدهما تحصيل العلم، لعدم البراءة إلا باليقين، والثاني الاخذ بالقدر المعلوم، لان الظاهر أن المسلم لا يفوت الصلاة.
ثم نسب كل الوجهين إلى الشافعية)، إنتهى.
وحكي هذا الكلام بعينه عن النهاية، وصرح الشهيدان بوجوب تحصيل العلم مع الامكان، و صرح في الرياض أيضا بأن مقتضى الاصل القضاء حتى يحصل العلم بالوفاء تحصيلا للبراءة اليقينية.
وقد سبقهم في هذا الاستدلال الشيخ، قدس سره، في التهذيب حيث قال: (أما ما يدل على أنه يجب أن يكثر منها فهو ما ثبت أن قضاء الفرائض واجب، وإذا ثبت وجوبها ولا يمكنه أن يتخلص من ذلك إلا بأن يستكثر منها وجب)، إنتهى.
وقد عرفت أن المورد من موارد جريان أصالة البراءة والاخذ بالاقل عند دوران الامر بينه و بين الاكثر، كما لو شك في مقدار الدين الذي يجب قضاؤه أو في أن الفائت منه صلاة العصر فقط أوهى مع الظهر، فإن الظاهر عدم إفتائهم بلزوم قضاء الظهر.وكذا لو تردد ما فات عن أبويه أو في ما تحمله بالاجارة بين الاقل والاكثر.
وربما يظهر من بعض المحققين الفرق بين هذه الامثلة وبين ما نحن فيه، حيث حكي عنه، في رد صاحب الذخيرة القائل بأن مقتضى القاعدة في المقام الرجوع إلى البراءة قال: (إن المكلف حين علم بالفوائت صار مكلفا بقضاء هذه الفائتة قطعا.و كذلك الحال في الفائتة الثانية والثالثة وهكذا.
ومجرد عروض النسيان كيف يرفع الحكم الثابت من الاطلاقات والاستصحاب بل الاجماع أيضا؟ وأي شخص يحصل منه التأمل في أنه إلى ما قبل صدور النسيان كان مكلفا، وبمجرد عروض النسيان يرتفع التكليف الثابت؟ وإن أنكر حجية الاستصحاب فهو يسلم أن الشغل اليقيني يستدعي البراءة اليقينية إلى أن قال: - نعم في الصورة
التي يحصل للمكلف علم إجمالي بإشتغال ذمته بفوائت متعددة يعلم قطعا تعددها، لكن لا يعلم مقدارها، فإنه يمكن حينئذ أن يقال: لا نسلم تحقق الشغل بأزيد من المقدار الذي تيقنه - إلى أن قال: - والحاصل: أن المكلف إذا حصل له القطع بإشتغال ذمته بمتعدد والتبس عليه ذلك كما، وأمكنه الخروج عن عهدته، فالامر كما أفتى به الاصحاب، وإن لم يحصل ذلك بأن يكون ما علم به خصوص إثنتين أو ثلاث.وأما أزيد عن ذلك فلا، بل إحتمال احتمله.فالامر كما ذكره في الذخيرة.
ومن هنا لو لم يعلم أصلا بمتعدد في فائتة وعلم أن صلاة صبح يومه فاتت، وأما غيرها فلا يعلم ولا يظن فوته أصلا، فليس عليه إلا الفريضة الواحدة دون الاكثر [ المحتمل خ ل ] لكون شكا بعد خروج الوقت، والمفروض أنه ليس عليه قضاؤها، بل لعله المفتي به)، إنتهى كلامه رفع مقامه.
ويظهر النظر فيه مما ذكرناه سابقا، ولا يحضرني الان حكم لاصحابنا بوجوب الاحتياط في نظير المقام، بل الظاهر منهم إجراء أصل البراءة في أمثال ما نحن فيه مما لا يحصى.
وربما يوجه الحكم فيما نحن فيه بأن الاصل عدم الاتيان بالصلاة الواجبة فيترتب عليه وجوب القضاء إلا في صلاة علم الاتيان بها في وقتها.
ودعوى: (ترتب وجوب القضاء على صدق الفوت الغير الثابت بالاصل، لا مجرد عدم الاتيان الثابت بالاصل)، ممنوعة، لما يظهر من الاخبار وكلمات الاصحاب من أن المراد بالفوت مجرد الترك كما بيناه في الفقه.
وأما ما دل على أن الشك في إتيان الصلاة بعد وقتها لا يعتد به لا يشمل ما نحن فيه.
وإن شئت تطبيق ذلك على قاعدة الاحتياط اللازم، فتوضيحه أن القضاء وإن كان بأمر جديد إلا أن ذلك الامر كاشف عن إستمرار مطلوبية الصلاة من عند دخول وقتها إلى آخر زمان التمكن من المكلف.
غاية الامر كون هذا على سبيل تعدد المطلوب بأن يكون الكلي المشترك بين ما في الوقت و خارجه مطلوبا.
وكون إتيانه في القوت مطلوبا آخر.كما أن أداء الدين ورد السلام واجب في أول أوقات الامكان.ولو لم يفعل ففي الان الثاني وهكذا.وحينئذ فإن دخل الوقت وجب إبراء الذمة
عن ذلك الكلي، فإذا شك في براءه ذمته بعد الوقت، فمقتضى حكم العقل بإقتضاء الشغل اليقيني للبراءة اليقينية وجوب الاتيان.كما لو شك في البراءة قبل خروج الوقت.
وكما لو شك في أداء الدين الفوري فلا يقال: إن الطلب في الزمان الاول قد إرتفع بالعصيان، ووجوده في الزمان الثاني مشكوك فيه، وكذلك جواب السلام.
والحاصل: أن التكليف المتعدد بالمطلق والمقيد لا ينافي جريان الاستصحاب وقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى المطلق فلا يكون المقام مجرى البراءة، هذا.
ولكن الانصاف: ضعف هذا التوجيه لم سلم إستناد الاصحاب إليه في القام.
أما أولا، فلان من المحتمل بل الظاهر، على القول بكون القضاء بأمر جديد، كون كل من الاداء والقضاء تكليفا مغايرا للاخر، فهو من قبيل وجوب الشئ ووجوب تداركه بعد فوته.كما يكشف عن ذلك تعلق أمر الاداء بنفس الفعل وأمر القضاء به بوصف الفوت.
ويؤيده بعض ما دل على أن لكل من الفرائض بدلا وهو قضاؤه عدى الولاية، لا من باب الامر بالكلي والامر بفرد خاص.
منه كقوله: صم وصم يوم الخميس أو الامر الكلى والامر بتعجيله كرد السلام وقضاء الدين فلا مجرى لقاعدة الاشتغال وإستصحابه وأما ثانيا، فلان منع عموم ما دل على أن الشك في الاتيان بعد خروج الوقت لا يعتد به للمقام حال السند، خصوصا مع إعتضاده بما دل على أن الشك في الشئ لا يعتنى به بعد تجازوه.
مثل قوله: عليه السلام: (إنما الشك في شئ لم تجزه)، ومع إعتضاده في بعض المقامات بظاهر حال المسلم في عدم ترك الصلاة.
وأما ثالثا، فلانه لو تم ذلك جرى فيما يقتضيه عن أبويه إذا شك في مقدار ما فات منهما.
ولا أظنهم يلتزمون بذلك، وإن إلتزموا بأنه إذا وجب على الميت لجهله بما فات به مقدار معين يعلم أو يظن معه البراءة وجب على الولي قضاء ذلك المقدار، لوجوبه ظاهرا على الميت، بخلاف ما لم يعلم بوجوبه عليه.
وكيف كان، فالتوجيه المذكور ضعيف.
وأضعف منه التمسك فيما نحن فيه بالنص الوارد ب (أن من عليه من النافلة ما لا يحصيه من كثرته قضى حتى لا يدري كم صلى من كثرته)، بناء على أن ذلك طريق لتدارك ما فات ولم يحص، لا أنه مختص بالنافلة، مع أن الاهتمام في النافلة بمراعاة الاحتياط يوجب ذلك في الفريضة بطريق أولى، فتأمل.
المطلب الثالث فيما دار الامر فيه بين الوجوب والحرمة
وفيه مسائل
[ المسألة ] الاولى: في حكم دوران الامر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما كما إذا اختلفت الامة على القولين بحيث علم عدم الثالث.
فلا ينبغي الاشكال في إجراء أصالة عدم كل من الوجوب والحرمة بمعنى نفي الاثار المتعلقة بكل واحد منهما بالخصوص إذا لم يلزم مخالفة علم تفصيلي، بل لو إستلزم ذلك على وجه تقدم في أول الكتاب في فروع إعتبار العلم الاجمالي.
وإنما الكلام هنا في حكم الواقعة من حيث جريان أصالة البراءة وعدمه، فإن في المسألة وجوها ثلاثة: الحكم بالاباحة ظاهرا، نظير ما يحتمل التحريم وغير الوجوب، والتوقف بمعنى عدم الحكم بشئ لا ظاهرا ولا واقعا، والتخيير.
ومحل هذه الوجوه ما لو كان كل من الوجوب و التحريم توصليا بحيث يسقط بمجرد الموافقة، إذ لو كانا تعبديين محتاجين إلى قصد إمتثال التكليف أو كان أحدهما كان المعين كذلك لم يكن.
ولا إشكال في عدم جواز طرحهما والرجوع إلى الاباحة، لانها مخالفة قطعية عملية.
وكيف كان، فقد يقال في محل الكلام بالاباحة ظاهرا، لعموم أدلة الاباحة الظاهرية، مثل قولهم: (كل شئ لك حلال)، وقولهم: (ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع)، فإن كلا من الوجوب والحرمة قد حجب عن العباد علمه.
وغير ذلك من أدلته، حتى قوله عليه السلام: (كل شئ مطلق حتى يرد فيه أمر أو نهي)، على رواية الشيخ، رحمه الله، إذ الظاهر ورود أحدهما بحيث يعلم تفصيلا، فيصدق هنا أنه لم يرد أمر ولا نهي.
هذا كله، مضافا إلى حكم العقل بقبح المؤاخذة على كل من الفعل والترك.
فإن الجهل بأصل الوجوب علة تامة عقلا بقبح العقاب على الترك من غير مدخلية لانتفاء إحتمال الحرمة فيه، وكذا الجهل بأصل الحرمة.
وليس العلم بجنس التكليف المردد بين نوعي الوجوب والحرمة، كالعلم بنوع التكليف المتعلق بأمر مردد، حتى يقال: إن التكليف في المقام معلوم إجمالا.
وأما دعوى (وجوب إلالتزام بحكم الله تعالى، لعموم دليل وجوب الانقياد للشرع)، ففيها أن المراد بوجوب الالتزام: إن أريد وجوب موافقة حكم الله فهو حاصل فيما نحن فيه، [ فإن ] في الفعل موافقة للوجوب وفي الترك موافقة للحرمة، إذ المفروض عدم توقف الموافقة على قصد الامتثال، وإن أريد وجوب الانقياد والتدين بحكم الله فهو تابع للعلم بالحكم، فإن علم تفصيلا وجب التدين به كذلك، وإن علم إجمالا وجب التدين بثبوته في الواقع.
ولا ينافى ذلك التدين حينئذ الحكم بإباحته ظاهرا، إذ الحكم الظاهري لا يجوز أن يكون معلوم المخالفة تفصيلا للحكم الواقعي من حيث العمل، لا من حيث التدين به.
ومنه يظهر إندفاع ما يقال من: (أن الالتزام وإن لم يكن واجبا باحدهما إلا أن طرحهما والحكم بالاباحة طرح لحكم الله الواقعي وهو محرم، وعليه يبنى عدم جواز إحداث القول الثالث إذا إختلفت الامة على القولين يعلم دخول الامام عليه السلام في أحدهما).
توضيح الاندفاع: أن المحرم، وهو الطرح في مقام العمل، غير متحقق.
والواجب في مقام التدين الالتزام بحكم الله على ما هو عليه في الواقع.
وهو أيضا متحقق، فلم يبق إلا وجوب تعبد المكلف وتدينه وإلتزامه بما يحتمل الموافقة للحكم الواقعي، وهذا مما لا دليل على وجوبه أصلا.
والحاصل: ان الواجب شرعا هو الالتزام والتدين بما علم أنه حكم الله الواقعي، ووجوب الالتزام بخصوص الوجوب بعينه أو الحرمة بعينها من اللوازم العقلية للعلم العادي التفصيلي يحصل من ضم صغرى معلومة تفصيلا إلى تلك الكبرى، فلا يعقل وجوده مع إنتفائه، وليس حكما شرعيا ثابتا في الواقع حتى يجب مراعاته ولو مع الجهل التفصيلي.
ومن هنا يبطل قياس ما نحن فيه، بصورة تعارض الخبرين الجامعين لشرائط الحجية الدال أحدهما على الامر والاخر على النهي، كما هو مورد بعض الاخبار الواردة في تعارض الخبرين.
ولا يمكن أن يقال: إن المستفاد منه بتنقيح المناط هو وجوب الخذ بأحد الحكمين وإن لم يكن على كل واحد منهما دليل معتبر معارض بدليل آخر.
فإنه يمكن أن يقال: إن الوجه في حكم الشارع هناك بالاخذ بأحدهما هو أن الشارع أوجب الاخذ بكل من الخبرين المفروض إستجماعهما لشرائط الحجية.
فإذا لم يمكن الاخذ بهما معا، فلا بد من الاخذ بأحدهما.
وهذا تكليف شرعي في المسألة الاصولية غير التكليف المعلوم تعلقه إجمالا في المسألة الفرعية بواحد من الفعل والترك، بل ولولا النص الحاكم هناك بالتخيير أمكن القول به من هذه الجهة، بخلاف ما نحن فيه، إذ لا تكليف إلا بالاخذ بما صدر واقعا في هذه الواقعة، والالتزام به حاصل من غير حاجة إلى الاخذ بأحدهما بالخصوص.
ويشير إلى ما ذكرمنا من الوجه قوله عليه السلام في بعض تلك الاخبار: (بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك).
وقوله عليه السلام: (من باب التسليم) إشارة إلى أنه لما وجب على المكلف التسليم لجميع ما يرد عليه بالطرق المعتبرة من أخبار الائمة عليهم السلام - كما يظهر ذلك من الاخبار الواردة في باب التسليم لما يرد من الائمة عليهم السلام.
منها قوله: (لا عذر لاحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا).
وكان التسليم لكلا الخبرين الواردين بالطرق المعتبرة المتعارضين ممتنعا - وجب التسليم لاحدهما مخيرا في تعيينه.
ثم إن هذا الوجه، وإن لم يخل عن مناقشة او منع، إلا أن مجرد إحتماله يصلح فارقا بين المقامين مانعا عن إستفادة حكم ما نحن فيه من حكم الشارع بالتخيير في مقام التعارض، فافهم.
فالاقوى في المسألة التوقف واقعا وظاهرا، فإن الاخذ بأحدهما قول بما لا يعلم لم يقم عليه دليل والعمل على طبق ما التزمه على أنه كذلك لا يخلو من التشريع.
وبما ذكرنا يظهر حال قياس ما نحن فيه على حكم المقلد عند إختلاف المجتهدين في الوجوب والحرمة.
وما ذكروه في مسألة إختلاف الامة لا يعلم شموله لما نحن فيه مما كان الرجوع إلى الثالث غير مخالف من حيث العمل لقول الامام، عليه السلام، مع ان عدم جواز الرجوع إلى الثالث المطابق للاصل ليس إتفاقيا.
على أن ظاهر كلام الشيخ القائل بالتخيير، كما سيجئ، هو إرادة التخيير الواقعي المخالف لقول الامام، عليه السلام، في المسألة.
ولذا اعترض عليه المحقق، رحمه الله، بأنه لا ينفع التخيير فرارا عن الرجوع إلى الثالث المطابق للاصل، لان التخيير أيضا طرح لقول الامام عليه السلام.
وإن إنتصر للشيخ بعض بأن التخيير بين الحكمين ظاهرا وأخذ أحدهما هو المقدار الممكن من الاخذ بقول الشارع في المقام.
لكن ظاهر كلام الشيخ يأبى عن ذلك قال في العدة:
(إذا إختلفت الامة على قولين فلا يكون إجماعا.
ولاصحابنا في ذلك مذهبان: منهم من يقول: إذا تكافأ الفريقان ولم يكن مع أحدهما دليل يوجب العلم أو يدل على أن قول المعصوم، عليه السلام، داخل فيه سقطا ووجب التمسك بمقتضى العقل من حظر أو إباحة على إختلاف مذاهبهم وهذا القول ليس بقوي.ثم علله باطراح قول الامام عليه السلام.
قال: ولو جاز ذلك لجاز مع تعيين قول الامام عليه السلام تركه والعمل بما في العقل.
و منهم من يقول: (نحن مخيرون في العمل بأي القولين.وذلك يجري مجرى الخبرين إذا تعارضا)، إنتهى.
ثم فرع: (على القول الاول جواز إتفاقهم بعد الاختلاف على قول واحد، و على القول الثانى عدم جواز ذلك، معللا بأنه يلزم من ذلك بطلان القول الاخر، و قد قلنا إنهم مخيرون في العمل ولو كان إجماعهم على أحدهما إنتقض ذلك)، إنتهى.
وما ذكره من التفريع أقوى شاهد على إرادة التخيير الواقعي، وإن كان القول به لا يخلو عن الاشكال.
[ هذا وقد مضى شطر من الكلام في ذلك في (المقصد الاول) من الكتاب، عند التكلم في الفروع إعتبار القطع فراجع].
وكيف كان، فالظاهر بعد التأمل في كلماتهم في باب الاجماع إرادتهم بطرح قول الامام عليه السلام، من حيث العمل، فتأمل.
ولكن الانصاف: أن أدلة الاباحة في محتمل الحرمة تنصرف إلى محتمل الحرمة وغير الوجوب و أدلة نفي التكليف عما لم يعلم نوع التكليف لا تفيد إلا عدم المؤاخذة على الترك أو الفعل وعدم تعيين الحرمة أو الوجوب.
وهذا المقدار لا ينافي وجوب الاخذ بأحدهما مخيرا فيه.
نعم هذا الوجوب يحتاج إلى دليل وهو مفقود، فاللازم هو التوقف وعدم الالتزام إلا بالحكم الواقعي على ما هو عليه في الواقع، ولا دليل على عدم جواز خلو الواقعة عن حكم ظاهري إذا لم يحتج إليه في العمل، نظير ما لو دار الامر بين الوجوب والاستحباب.
ثم على تقدير وجوب الاخذ، هل يتعين الاخذ بالحرمة أو يتخير بينه وبين الاخذ بالوجوب و
جهان بل قولان: يستدل على الاول، بعد قاعدة الاحتياط حيث يدور الامر بين التخيير والتعيين، بظاهر ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة، فإن الظاهر من التوقف ترك الدخول في الشبهة، وبأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، لما عند النهاية: (أن الغالب في الحرمة دفع مفسدة ملازمة للفعل وفي الوجوب تحصيل مصلحة لازمة للفعل، واهتمام الشارع والعقلاء بدفع المفسدة أتم، و [ يشهد له ما أرسل عن أمير المؤمنين، عليه السلام، من: (أن إجتناب السيئات أولى من إكتساب الحسنات).
وقوله عليه السلام: (إجتناب السيئات أفضل من إكتساب الحسنات) ].
ولان إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتم من إفضاء الوجوب إلى مقصوده، لان مقصود الحرمة يتأتي بالترك، سواء كان مع قصد أم غفلة، بخلاف فعل الواجب)، إنتهى.
وبالاستقراء، بناء على أن الغالب في موارد إشتباه مصاديق الواجب والحرام تغليب الشارع لجانب الحرمة.
مثل له بأيام الاستظهار وتحريم إستعمال الماء المشتبه بالنجس.ويضعف الاخير بمنع الغلبة.
وما ذكر من الامثلة مع عدم ثبوت الغلبة بها خارج عن محل الكلام، فإن ترك العبادة في أيام الاستظهار ليس على سبيل الوجوب عند المشهور، ولو قيل بالوجوب.ولعله لمراعاة أصالة بقاء الحيض وحرمة العبادة.
وأما ترك غير ذات الوقت العبادة بمجرد الرؤية فهو للاطلاقات وقاعدة كل ما أمكن.وإلا فأصالة الطهارة وعدم الحيض هي المرجع.
وأما ترك الانائين المشتبهين في الطهارة، فليس من دوران الامر بين الواجب والحرام، لان الظاهر، كما ثبت في محله، أن حرمة الطهارة بالماء النجس تشريعية لا ذاتية.وإنما منع عن الطهارة مع الاشتباه لاجل النص، مع أنها لو كانت ذاتية.فوجه ترك الواجب وهو الوضوء ثبوت البدل له وهو التيمم.كما لو إشتبه إناء ذهب بغيره مع إنحصار الماء في المشتبهين.وبالجملة، فالوضوء من جهة ثبوت البدل له لا يزاحم محرما.
مع أن القائل بتغليب جانب الحرمة لا يقول بجواز المخالفة القطعية في الواجب لاجل تحصيل الموافقة القطعيه في الحرام، لان العلماء والعقلاء متفقون على عدم جواز ترك الواجب تحفظا عن الوقوع في الحرام.
فهذا مثال أجنبي عما
نحن فيه قطعا.ويضعف ما قبله بأنه يصلح وجها لعدم تعيين الوجوب لا لنفي التخيير.
وأما أولوية دفع المفسدة فهي مسلمة، لكن المصلحة الفائتة بترك الواجب أيضا مفسدة وإلا لم يصلح للالزام، إذ مجرد فوات المنفعة عن الشخص وكون حاله بعد الفوت كحاله فيما قبل الوجوب عليه لا يصلح وجها لالزام شئ على المكلف ما لم يبلغ حدا يكون في فواته مفسدة وإلا لكان أصغر المحرمات أعظم من ترك أهم الفرائض مع أنه جعل ترك الصلاة أكبر الكبائر.
وبما ذكرنا يبطل قياس ما نحن فيه على دوران الامر بين فوت المنفعة الدنيوية وترتب المضرة الدنيوية، فإن فوات النفع من حيث هو نفع لا يوجب ضررا.وأما الاخبار الدالة على التوقف، فظاهرة فيما لا يحتمل الضرر في تركه، كما لا يخفى.وظاهر كلام السيد الشارح للوافية جريان أخبار الاحتياط أيضا في المقام، وهو بعيد.
وأما قاعدة الاحتياط عند الشك في التخيير والتعيين فغير جار في أمثال المقام، مما يكون الحاكم فيه العقل، فإن العقل إما ان يستقل بالتخيير، وأما أن يستقل بالتعيين.
فليس في المقام شك على كل تقدير، وإنما الشك في الاحكام التوقيفية التي لا يدركها العقل.
إلا أن يقال: إن احتمال أن يرد من الشارع حكم توقيفي في ترجيح جانب الحرمة، ولو لاحتمال شمول أخبار التوقف لما نحن فيه، كاف في الاحتياط والاخذا بالحرمة.
ثم لو قلنا بالتخيير، فهل هو في إبتداء الامر فلا يجوز له العدول عما اختار، أو مستمر فله العدول مطلقا أو بشرط البناء على الاستمرار وجوه.
يستدل للاول بقاعدة الاحتياط وإستصحاب حكم المختار وإستلزام العدول للمخالفة القطعية المانعة عن الرجوع التي لم يرجع إلى الاباحة من أول الامر حذرا منها.ويضعف الاخير بأن المخالفة القطعية في مثل ذلك لا دليل على حرمتها.
كما لو بدا للمجتهد في رأيه أو عدل المقلد عن مجتهده لعذر من موت أو جنون أو فسق أو إختيار على القول بجوازه.
ويضعف الاستصحاب بمعارضة إستصحاب التخيير الحاكم عليه.
ويضعف قاعدة الاحتياط بما تقدم من أن حكم العقل بالتخيير عقلي لا احتمال فيه حتى يجري فيه الاحتياط.
ومن ذلك يظهر عدم جريان إستصحاب التخيير، إذ لا إهمال في حكم العقل حتى يشك في بقائه في الزمان الثاني.
فالاقوى هو التخيير الاستمراري، لا للاستصحاب، بل لحكم العقل في الزمان الثاني كما حكم به في الزمان الاول.
المسألة الثانية: إذا دار الامر بين الوجوب والحرمة من جهة إجمال الدليل إما حكما، كالامر المردد بين الايجاب والتهديد، أو موضوعا، كما أمر بالتحرز عن أمر مردد بين فعل الشي ء وتركه، فالحكم فيه كما في المسألة السابقة.
المسألة الثالثة: لو دار الامر بين الوجوب والتحريم من جهة تعارض الادلة.
فالحكم هنا التخيير لاطلاق الادلة وخصوص بعض منها الوارد في خبرين أحدهما أمر والاخر نهي، خلافا للعلامة، رحمه الله، في النهاية وشارح المختصر والآمدي، فرجحوا ما دل على النهي، لما ذكرنا سابقا ولما هو أضعف منه.
وفي كون التخيير هنا بدويا أو إستمراريا، مطلقا أو مع البناء من أول الامر على الاستمرار وجوه تقدمت، إلا أنه قد يتمسك هنا للاستمرار بإطلاق الاخبار.
ويشكل بأنها مسوقة لبيان حكم المتحير في أول الامر، ولا تعرض لها لحكمه بعد الاخذ بأحدهما.
نعم يمكن هنا إستصحاب التخيير حيث أنه ثبت بحكم الشارع القابل للاستمرار إلا أن يدعى أن موضوع المستصحب أو المتيقن من موضوعه هو المتحير، وبعد الاخذ بأحدهما لا تحير، فتأمل.
وسيتضح هذا في بحث الاستصحاب، وعليه فاللازم الاستمرار على ما اختار، لعدم ثبوت التخيير في الزمان الثاني.
المسألة الرابعة: لو دار الامر بين الوجوب والحرمة من جهة إشتباه الموضوع وقد مثل بعضهم له بإشتباه الحليلة الواجب وطيها بالاصالة أو لعارض من نذر أو غيره بالاجنبية، وبالخل المحلوف على شربه المشتبه بالخمر.
ويرد على الاول أن الحكم في ذلك هو تحريم الوطي، لاصالة عدم الزوجية بينهما وأصالة عدم وجوب الوطي.
وعلى الثاني أن الحكم عدم وجوب الشرب وعدم حرمته، جمعا بين أصالتي الاباحة وعدم الحلف على شربه.
والاولى فرض المثال فيما إذا وجب إكراه العدول وحرم إكرام الفساق وإشتبه حال زيد من حيث الفسق والعدالة والحكم فيه.
كما في المسألة الاولى من عدم وجوب الاخذ بأحدهما في الظاهر، بل هنا أولى، إذ ليس فيه إطراح لقول الامام عليه السلام، إذ ليس الاشتباه في الحكم الشرعي الكلي الذي بينه الامام عليه السلام، وليس فيه ايضا مخالفة عملية معلومة ولو إجمالا، مع أن مخالفة المعلوم إجمالا في العمل فوق حد الاحصاء في الشبهات الموضوعية.
هذا تمام الكلام في المقامات الثلاثة، أعني دوران الامر بين الوجوب وغير الحرمة، وعكسه، ودوران الامر بينهما.
وأما دوران بين ما عدا الوجوب والحرمة من الاحكام فيعلم بملاحظة ما ذكرنا.
وملخصه: أن دوران الامر بين طلب الفعل والترك وبين الاباحة نظير المقامين الاولين، و دوران الامر بين الاستحباب والكراهة نظير المقام الثالث.
ولا إشكال في اصل هذا الحكم، إلا أن إجراء أدلة البراءة في صورة الشك في الطلب الغير الالزامى فعلا أو تركا قد يستشكل فيه، لان ظاهر تلك الادلة نفي المؤاخذة والعقاب والمفروض إنتفاؤهما في غير الواجب والحرام، فتدبر (انتهى المجلد الاول) إعتذار
بعد طبع هذا الكتاب عرفنا بأن مقابلته الاخيرة لم تكن نقية ومنقحة ولم تقابل مع نسخة " رحمة الله " التي هي كثيرا ما تكون بأيدي الطلاب - وفقهم الله - ولذلك وقع إختلاف كثير فيه، هذا وقد أشرنا في هذه الصفحة إلى بعض العبارات التي تكون موجودة في نسخة " رحمة الله " والتي لم تذكر في بقية النسخ كي تكون موردا لافادة الطلاب عند المراجعة إليها.
الفهرس
المقصد الاول في القطع ٤
مقدمة ٤
الامرالاول:هل القطع حجة سواء صادف الواقع أم لم يصادف ٨
الامرالثاني: هل القطع الحاصل من المقدمات العقلية حجة ١٥
الامرالثالث: قد إشتهر في ألسنة المعاصرين أن قطع القطاع لا إعبار به ٢٢
الامرالرابع: إن المعلوم إجمالا هل هو كالمعلوم بالتفصيل في الاعتبار أم لا؟ ٢٤
المقصد الثاني في الظن ...المقام الاول: إمكان التعبد بالظن عقلا ٤٠
المقام الثاني: في وقوع التعبد بالظن في الاحكام الشرعية ٤٩
الظنون المعتبرة ٥٤
القسم الاول وهو ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم ٥٥
القسم الثاني وهو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر ٧٤
المقدمة الاولى: وهي إنسداد باب العلم والظن الخاص في معظم المسائل الفقهية ١٨٥
المقدمة الثانية: وعي عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة على كثرتها ١٨٦
المقدمة الثالثة: في بيان بطلان وجوب تحصيل الامتثال ١٩٥
المقدمة الرابعة في أنه إذا وجب التعرض لامتثال ٢١٠
المقام الثالث: تعميم الظن على تقرير الكشف أو على تقرير الحكومة ٢٥٣
القسم الثاني: الذي يجب الاعتقاد به إذا حصل العلم به ٢٧٥
القسم الاول: الذي يجب فيه النظر لتحصيل الاعتقاد ٢٨٢
[ المقام ] الاول في القادر ٢٨٢
المقام الثاني في غير المتمكن من العلم ٢٨٥
المقام الاول: الجبر بالظن الغير المعتبر ٢٩١
المقام الثاني: في كون الظن الغير المعتبر موهنا ٢٩٤
المقام الثالث: في الترجيح بالظن الغير المعتبر ٢٩٧
القسم الاول: وهو الظن الذي ورد النهي عنه بالخصوص ٢٩٧
القسم الثاني : وهو الترجيح بالظن الغير المعتبر في وجه الصدور ٢٩٩
أما المقام الثالث وهو ترجيح السند بمطلق الظن ٣٠٠
المقصد الثالث من مقاصد الكتاب في الشك ٣٠٨
مقدمة ٣٠٨
المقام الاول : وهو حكم الشك في الحكم الواقعي ٣١٣
الموضع الاول: وهو الشك في نفس التكليف ٣١٤
المطلب الاول: فيما دار الامر فيه بين الحرمة وغير الوجوب ٣١٥
المطلب الثاني في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة من الاحكام ٣٧٨
المطلب الثالث فيما دار الامر فيه بين الوجوب والحرمة ٣٩٦