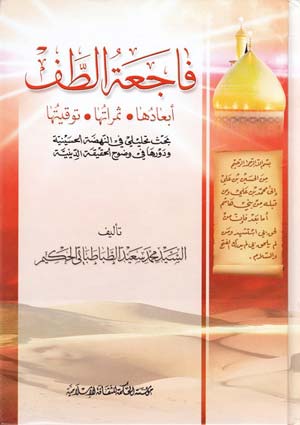بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسّلام على سيّدنا محمد وآله الطيّبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
وبعد، فقد كثر الحديث عن نهضة الإمام الحسين (صلوات الله عليه) التي انتهت بفاجعة الطفّ عرضاً وتقييماً، وتفجّعاً وافتخاراً، وغير ذلك من شؤون هذه الملحمة الدينية الكبرى.
ولعلّه لم تحظَ واقعة في الإسلام، بل في العالم بمثل ما حظيت به هذه الواقعة من الاهتمام والتقييم في أحاديث وكتابات بلغ كثير منها كتباً كاملة، بل مجلّدات.
وذلك قد يوحي بأنّ الحديث عنها بعد ذلك لا يزيد شيء، بل هو تكرار لأفكار سابقة، واجترار لمفاهيم مطروحة.
ولكنّ الذي يبدو لنا أنّ الأمر ليس كذلك، وأنّ بعض جوانب هذه النهضة المباركة لم يأخذ حظّه المناسب من البحث والتقييم.
بل حيث كانت هذه النهضة المقدّسة - حسب عقيدتنا كمسلمين شيعة إمامية اثني عشرية نستمد تعاليمنا من أئمّة أهل البيت (صلوات الله عليهم) - بأمر من الله تعالى وعهد معهود منه سبحانه، فقد تكون لها من الأهداف والثمرات في علم الله (عزّ وجلّ) ما لم يدركه الناس بعد.
وربما يظهر بمرور الزمن، وفي الوقت المناسب من فوائدها وثمراتها ما هو مغفول عنه الآن. يقول الله سبحانه وتعالى:( وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء ) (١) .
وها نحن نضع بين يدي القارئ الكريم كتاب (فاجعة الطفّ) الذي بحثنا فيه جوانب مهمّة من نهضة الإمام الحسين (صلوات الله عليه) لم تُطرق من قبل، أو لم تأخذ حظّها المناسب من البحث والتقييم.
وقد اخترنا للكتاب هذا العنوان؛ من أجل أنّ أهمية هذه النهضة المباركة، وموقعها المتميز من بين الأحداث في خلوده، وترتّب الثمرات الجليلة عليه، وما أحدثته من هزّة في المجتمع الإسلامي، وتحوّل في نظرته للسلطة، كلّ ذلك إنّما كان بلحاظ وجهها الدامي، وجانبها المفجع، وظُلامتها الصارخة؛ ولذا أكّد أئمّة أهل البيت (صلوات الله عليهم) على هذا الجانب بوجه ملفت للنظر.
عرض موجز لمحتويات الكتاب
نعم، العنوان المذكور قد يوحي في بدو النظر بأنّ الكتاب يتضمّن أحداث الفاجعة، وسرد مفرداته على غرار المقاتل الكثيرة التي أُلفت في هذا المجال، مع أنّ الكتاب أبعد ما يكون عن ذلك. ومن هنا ألحقنا بالعنوان المذكور المفردات التالية:
أبعاده. ثمراته. توقيته.
لنشير بذلك إلى الجوانب المهمّة التي عني بها الكتاب. وقد خصّصنا كلاً منها بمقصد يستوفي الكلام فيه.
وبعدُ انتهى الكتاب بهذا الحجم غير المتوقّع، وبالمادة الغزيرة التي تضمّنها، فالظاهر أنّ الإشارة لمضمونه بهذا الاختزال لا تكفي في إعطاء صورة إجمالية
____________________
(١) سورة البقرة/٢٥٥.
للقارئ عن محتواه؛ لذا كان من المناسب عرض محتوى المقاصد الثلاثة بإيجاز.
فالمقصد الأوّل: الذي هو في أبعاد الفاجعة يتضمّن بيان المفردات المأساوية والمثيرة التي تجمّعت في الفاجعة، وجعلتها في قمّة المآسي الدينية والإنسانية، وبالحجم المناسب لخلوده، ولما ترتب عليها من آثار جليلة.
وتأكيد ذلك بما ظهر من ردود الفعل السريعة لها مع التعرّض لهوله:
أولاً: في المجتمع الإسلامي، حيث أجّجت عواطفهم بنحو أظهرت غضبه على السلطة وبغضه له.
وثانياً: في السلطة التي قارفت الجريمة نفسها، حيث شعرت بالخيبة والخسران، واضطرت للتراجع عن عنفوانها فيما يخصّ الحدث، والتنصّل من الجريمة في محاولة يائسة.
والمقصد الثاني: الذي هو في ثمرات الفاجعة ومكاسبه، فقد ذكرنا فيه أنّ المكاسب المذكورة على قسمين:
الأوّل: المكاسب الدينية، ولها الموقع الأهم في الحدث، والأوفى بحثاً وتقييماً في هذا الكتاب، وهي ذات جانبين:
١ - مكاسب الإسلام بكيانه العام.
وحيث كانت نهضة الإمام الحسين (صلوات الله عليه) في ضمن سلسلة جهود أهل البيت (عليهم السّلام) في رعاية الإسلام، والحفاظ على الدين، وإيضاح معالمه، فقد ألزمنا ذلك التعرّض:
أوّلاً: لخطر التحريف الذي تعرّض له دين الإسلام؛ نتيجة انحراف السلطة، وخروجها عن أهل البيت (صلوات الله عليهم). وقد أفضنا في خطوات السلطة المتلاحقة، ومشروعها في التعتيم على الحقائق والتحكّم في
الدين، وفي حجم الخطر لو تُرك الأمر لها، ولم يُكبح جماحها.
وثانياً: لجهود أهل البيت (صلوات الله عليهم) في كبح جماح الانحراف والتحريف.
ولبيان المراحل التي قطعها أهل البيت (عليهم السّلام) في سبيل ذلك استعرضنا جهود أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسّلام) والخاصّة من أصحابه (رضوان الله عليهم) في كشف الحقائق، والتركيز عليه، والإنكار على الانحراف في السلطة، وعلى تحكّمها في الدين وتحريفه، وما جرى مجرى ذلك.
ثمّ تأكيده هو (عليه السّلام) حينما استولى على السلطة، وتأكيدهم معه على حقّه وحق أهل البيت (عليهم السّلام)، واهتمامهم بإحياء دعوة التشيّع التي غرسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وكانت نتيجة ذلك أن تبنّى هذه الدعوة الحقّة جماعة من ذوي المقام الرفيع في الدين، والأثر المحمود في الإسلام، ومن ذوي التصميم والإصرار، واقتنعوا بها كعقيدة محدّدة المعالم، مدعومة بالأدلّة، مناسبة للفطرة، وبالدعوة لها، ومحاولة التبليغ بها وتعميمها في المجتمع الإسلامي، وبالإنكار على انحراف السلطة وتحريفها للدين، وتعرية الظالمين.
ثمّ استعرضنا جهود السلطة بعد أمير المؤمنين (عليه السّلام) في الوقوف بوجه هذه الدعوة، والقضاء على حملته، والمضي في الانحراف والتحريف، وإسكات أصوات الإنكار عليه وعلى السلطة بالترغيب والترهيب، وإماتة الوازع الديني والضمير الإنساني في الأُمّة.
كلّ ذلك من أجل انفراد السلطة في الساحة، وتنفيذ مشروعها في استغلال قدرات الإسلام المادية والمعنوية، والتحكّم بالدين لصالحها وخدمة أهدافها.
ونبّهنا إلى تفاقم الأمر ببيعة معاوية بولاية العهد من بعده ليزيد، وتحويل الدولة الإسلامية إلى دولة قيصرية أُموية سفيانية ذات أهداف جاهلية.
وإلى أنّ جهود أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) السابقة أصبحت بسبب ذلك في خطر حقيقي.
وهنا جاء دور الإمام الحسين (صلوات الله عليه) ليقف في وجه السلطة، وليعلن الإنكار عليه، وعدم شرعيته، ويفجّر الموقف بفاجعة الطفّ الدامية التي هزّت ضمير المسلمين، وبغّضت السلطة للناس وأسقطت شرعيتها عندهم.
وكان المكسب المهمّ للدين في ذلك فصله عن السلطة غير المعصومة، وتحرّره من أن تتحكّم فيه، ورجوع المسلمين لواقعهم في الاعتراف بانحصار المرجع في الدين بالكتاب المجيد والسُنّة الشريفة، واتّفاقهم على جملة من معالم الدين التي تحفظ وحدتهم وتذكّرهم بمشتركاتهم.
٢ - مكاسب التشيع بخصوصيته.
تارة: من حيثية الاستدلال والبرهان، وقوّة الحجّة بسبب الفاجعة.
وأُخرى: في الجانب العاطفي، حيث فاز التشيّع بشرف التضحية في أعظم ملحمة دينية تُأجج العواطف وتُثير المشاعر.
وثالثة: في الإعلام، وبيان حقيقة التشيّع والدعوة له، ونشر ثقافته الأصيلة المناسبة للفطرة في مختلف جهات المعرفة.
الثاني: في العبر التي تستخلّص من الفاجعة من أجل أن ينتفع بها ذوو الرشد.
وقد اقتصرنا منها على أمرين:
أوّلهما: سلامة آلية التحرّك والعمل، والحفاظ فيها على المبادئ الدينية والإنسانية السامية.
ثانيهما: ظهور واقع الناس، ومدى استجابتهم لدعوى الحق، والثبات
عليه، والوقوف عند تعاليمه، ممّا يكشف عن تعذّر الإصلاح التام، وإقامة حكم إسلامي بنحو كامل، وإنّه يتعيّن الاكتفاء بالإصلاح النسبي حسب المقدور من دون أن ينافي ذلك شمولية الإسلام في نفسه، وكمال تشريعه الرفيع.
أمّا المقصد الثالث: فقد تحدّثنا فيه عن توقيت النهضة المباركة التي انتهت بالفاجعة، والظروف المناسبة التي هيّأت للإمام الحسين (صلوات الله عليه) القيام بها دون بقيّة الأئمّة ممّن سبقه ولحقه، مع أنّ وظيفتهم (صلوات الله عليهم) بأجمعهم هي رعاية الدين والجهاد في سبيل صلاحه وحمايته.
وقد أوضحنا في المقصد المذكور عدم سنوح الفرصة المناسبة لتفجير الموقف إلّا في عهد الإمام الحسين (صلوات الله عليه)، وفي ذلك المنعطف التاريخي من مسيرة الإسلام خاصة دون ما قبله وما بعده.
وقد استعرضنا من أجل ذلك:
أوّلاً: موقف أمير المؤمنين (عليه أفضل الصّلاة والسّلام)، وظرفه الحرج الذي ألزمه بالمسالمة والسكوت.
وثانياً: موقف الإمام الحسن (صلوات الله عليه) الذي اضطر فيه لمهادنة معاوية، وثمرات ذلك لصالح الإسلام عموماً ودعوة التشيع خاصّة.
وثالثاً: موقف الأئمّة من ذريّة الحسين (صلوات الله عليهم). حيث كفتهم فاجعة الطفّ مؤنة السعي لإسقاط شرعيّة السلطة، وتحرير الدين منه، واستغنوا بالفاجعة المذكورة عن مواجهة السلطة والاحتكاك به.
وكيف أنّهم (عليهم السّلام) استثمروا جهود الأئمّة الأوّلين (صلوات الله عليهم) - وفي قمّتها تلك الفاجعة - لصالح الدين، وتفرّغوا لبناء الكيان الشيعي بمميّزاته الحالية - في العقيدة والبنية والممارسات - بالنحو الذي ضمن له الاستمرار والبقاء، والتوسّع والانتشار، وفرض احترامه على الآخرين.
كما قدّمنا هذا الكتاب بمقدّمة أوضحنا فيها أنّ التخطيط لفاجعة الطفّ كان إلهي، وقد علم به الإمام الحسين (صلوات الله عليه) مسبقاً، وأقدم على التضحية في سبيل الله تعالى عالماً بالنتائج، وأنّه بذلك تتجلّى رفعة مقامه، وعظمة موقفه، وفناؤه في ذات الله (عزّ وجلّ).
أمّا الخاتمة التي ختمنا بها هذا الكتاب فهي تتضمّن:
أوّلاً: بيان أنّ لجهود أهل البيت (صلوات الله عليهم) - وفي قمّتها فاجعة الطفّ - في كبح جماح الانحراف، وإيضاح معالم الدين الفضل على جميع الأديان السماوية في التنبيه على رفعتها وسلامتها ممّا نسبته لها يد التحريف، بل لها الفضل في استقامة مسار الفكر الإنساني، وإيضاح المعالم العامّة لمنهج التفكير السليم.
وثانياً: بيان كثير ممّا يتعلّق بإحياء فاجعة الطفّ ومناسبات أهل البيت (صلوات الله عليهم) في أفراحهم وأحزانهم، وجميع المناسبات الدينية الشريفة.
ونأمل أن تتمّ للقارئ بهذا العرض الموجز صورة إجمالية عمّا تضمّنه هذا الكتاب.
ونسأل الله (عزّ وجلّ) أن يجعله مورد نفع لطالبي الحقيقة والباحثين عنه، ومنه سبحانه نستمدّ التوفيق والتسديد، إنّه ولي الأمور، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
المقدّمة
يشيع بين أهل الحديث من الفريقين والمؤرّخين عامّة عرض حادثة الطفّ الفجيعة والحديث عنه.
ولهم في ذلك اتّجاهان:
نظرية أنّ التخطيط لواقعة الطفّ بَشريّ
أوّلهما: أنّ التخطيط لها كان بشري، وأنّ الإمام الحسين (صلوات الله عليه) قد خطّط للنهضة وفق قناعاته وحساباته الماديّة؛ من أجل الاستيلاء على السلطة، وكان لمزاجيّته في التعامل مع الأحداث، وموقفه الحدّي الانفعالي من خصومه عامّة، ومن يزيد خاصّة، أعظم الأثر في ذلك.
بل قد يظهر من بعضهم أنّ ذلك قد أفقده النظرة الموضوعيّة في تقييم الظروف المحيطة به، والموازنة بين القوى التي له والتي عليه، وأنّه قد اغترّ بمواعيد مَنْ كتب له من أهل الكوفة، أو انخدع بنصيحة ابن الزبير له بالخروج(١) ، ليخلو له الحجاز.
وعلى كلّ حال فهو (عليه السّلام) عند أهل هذا الاتجاه قد حاول بخروجه تنفيذ مخطّطه في الاستيلاء على السلطة، إلّا أنّه لم يتسنَّ له ما أراد؛ لخطئه في تقييم
____________________
١ - تاريخ دمشق ١٤/٢٣٩ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، تهذيب الكمال ٦/٤٤٠ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، ترجمة الإمام الحسين (عليه السّلام) من طبقات ابن سعد/٨٦ ح ٢٩٩.
الأوضاع التي عاشها، ولحزم خصومه وصرامتهم، وخيانة مَنْ دعاه وتعهّد بنصره من أهل الكوفة، حتى انتهى الأمر إلى قتله وقتل مَنْ معه، والإجهاز على مشروعه، كما توقّع ذلك كثير من أهل الرأي والمعرفة، وقد نصحه كثير منهم - من أجل ذلك - بعدم الخروج.
وهذا هو الذي يظهر من كثير ممّن تعرّض لنهضة الإمام الحسين (صلوات الله عليه) من الجمهور.
نظرية أنّ التخطيط للواقعة إلهي
ثانيهما: أنّ التخطيط لها إلهي، وأنّ الله سبحانه وتعالى قد عهد للإمام الحسين (صلوات الله عليه)، وأمره - عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتنفيذ مشروع ينتهي باستشهاده واستشهاد مَنْ معه، وجميع ما حدث من مآسٍ وفجائع.
وكان له (عليه السّلام) بما يمتلك من مؤهّلات ذاتية وشخصية الدور المتميّز في تنفيذ المشروع المذكور وفاعليته، وتحقيق أهدافه السامية.
كلّ ذلك لمصالح عظمى تناسب حجم التضحية وأهميتها قد علم الله (عزّ وجلّ) بها. وربما ظهر لنا بعضها.
وقد نجح (صلوات الله عليه) في مشروعه، وحقّق ما أراد، وتكلّل سعيه بالنجاح والفلاح، وكان عاقبته الفتح المبين.
وأنّ مَنْ أشار عليه بعدم الخروج قد خفي عليهم وجه الحكمة، كما خفي على المسلمين وجه الحكمة في صلح الحديبية؛ فاستنكروه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما خفي على كثير من أصحاب الإمام الحسن (صلوات الله عليه) وغيرهم وجه الحكمة في صلحه لمعاوية؛ فأنكروا عليه... إلى غير ذلك من الأمور الغيبية التي قد يخفى وجهها. والناس أعداء ما جهلوا، بل قد يكونون معذورين لجهلهم.
ونحن الشيعة حيث إنّنا نؤمن بعصمة الإمام الحسين وسائر الأئمّة (صلوات الله عليهم) لا بدّ من أن نتبنّى التفسير الثاني للنهضة المباركة، ولجميع ما صدر من الأئمّة (صلوات الله عليهم) في التعامل مع الأحداث.
تأكيد النصوص على أنّ التخطيط لفاجعة الطفّ إلهي
ومع ذلك فنصوصنا مستفيضة عن النبي والأئمّة (صلوات الله عليهم أجمعين) بما يؤكّد التفسير المذكور.
نكتفي منها بصحيح ضريس الكناسي عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر (عليه السّلام) قال: قال له حمران: جُعلت فداك! أرأيت ما كان من أمر علي والحسن والحسين (عليهم السّلام)، وخروجهم وقيامهم بدين الله (عزّ وجلّ)، وما أُصيبوا من قتل الطواغيت إيّاهم والظفر بهم حتى قُتلوا وغُلبوا؟
فقال أبو جعفر (عليه السّلام): «يا حمران، إنّ الله تبارك وتعالى [قد] كان قدّر ذلك عليهم وقضاه، وأمضاه وحتمه، ثمّ أجراه؛ فبتقدّم علم ذلك إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام علي والحسن والحسين (عليهم السّلام)، وبعلم صمت مَنْ صمت منّا»(١) .
وحديث العمري عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليه السّلام) قال: «إنّ الله (عزّ وجلّ) أنزل على نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم كتاباً قبل وفاته، فقال: يا محمّد هذه وصيتك إلى النُجَبَة من أهلك... فدفعه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام) وأمره أن يفكّ خاتماً منه ويعمل بما فيه، ففكّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) خاتم وعمل بما فيه، ثمّ دفعه إلى ابنه الحسن (عليه السّلام) ففكّ خاتماً منه وعمل بما فيه، ثمّ دفعه إلى الحسين (عليه السّلام) ففكّ خاتماً فوجد فيه: أن اخرج بقومٍ إلى الشهادة، فلا شهادة لهم إلّا معك، واشترِ نفسك لله (عزّ وجلّ)؛ ففعل، ثمّ دفعه إلى عليّ بن الحسين (عليهم السّلام)...»(٢) .
____________________
١ - الكافي ١/٢٦٢.
٢ - الكافي ١/٢٨٠.
الشواهد المؤكّدة لكون التخطيط للفاجعة إلهي
بل نحن نرى أنّ التفسير الأوّل ظلمٌ لسيّد الشهداء (صلوات الله عليه)، واستهوان بنهضته المقدّسة؛ وهو يبتني على تجاهل كثير من الحقائق الثابتة تاريخياً، كما يظهر ممّا يأتي إن شاء الله.
إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت بالفاجعة قبل وقوعها
وليس ذلك من أجل اعتقادنا بعصمة الإمام الحسين (عليه السّلام)، ولا من أجل الأحاديث التي أشرنا إليها، بل لأنّه قد استفاض الحديث، بل تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين (صلوات الله عليه) وأهل البيت (عليهم السّلام) بمقتل الإمام الحسين (صلوات الله عليه)، كما استفاض الحديث عن الإمام الحسين (عليه السّلام) نفسه بذلك.
ويتّضح ذلك بالرجوع لمصادر الحديث والتاريخ الكثيرة، ويأتي منّا ذكر كثير من ذلك.
توقّع الناس للفاجعة قبل وقوعها
بل يبدو أنّ ذلك قد شاع وعُرف بين الناس قبل حصوله؛ فقد روي أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب في المسلمين، وأخبرهم بقتل الحسين (عليه السّلام) فضجّ الناس بالبكاء، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أتبكون ولا تنصرونه؟!...»(١) .
وروى الطبراني بسنده عن عائشة حديثاً طويلاً يتضمّن إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها بقتل الإمام الحسين (عليه السّلام) بالطفّ، وفيه: ثمّ خرج إلى أصحابه - فيهم علي وأبو بكر وعمر وحذيفة وعمّار وأبو ذرّ (رضي الله عنهم) - وهو يبكي، فقالوا: ما يبكيك يا رسول الله؟!
فقال: «أخبرني جبرئيل أنّ ابني الحسين يُقتل بعدي بأرض الطفّ، وجاءني
____________________
١ - مقتل الحسين - للخوارزمي ١/١٦٤ الفصل الثامن، واللفظ له، الفتوح - لابن أعثم ٤/٣٢٨ ابتداء أخبار مقتل مسلم بن عقيل والحسين بن علي وولده، بحار الأنوار ٤٤/٢٤٨.
بهذه التربة، وأخبرني أنّ فيها مضجعه»(١) .
وعن ابن عباس أنه ذكر خطبة النبي (صلى الله عليه واله وسلم) في ذلك وقال: "ثم نزل عن المنبر، ولم يبق أحد من المهاجرين والأنصار إلا وتيقن بأن الحسين مقتول"(٢) .
كما أسند غير واحد عن ابن عباس أنّه قال: ما كنّا نشكّ وأهل البيت متوافرون أنّ الحسين بن علي يُقتل بالطفّ(٣) .
وقال الشيخ المفيد: وروى عبد الله بن شريك قال: كنت أسمع أصحاب علي (عليه السّلام) إذا دخل عمر بن سعد من باب المسجد يقولون: هذا قاتل الحسين بن علي (عليه السّلام)، وذلك قبل قتله بزمان(٤) .
وروي أنّ عمر بن سعد قال للإمام الحسين (صلوات الله عليه): «إنّ قوماً من السفهاء يزعمون أنّي أقتلك». فقال له الإمام الحسين (عليه السّلام): «ليسوا بسفهاء، ولكنّهم حلماء. ثمّ قال: والله إنّه ليقرّ بعيني أنّك لا تأكل برّ العراق بعدي إلّا قليلاً»(٥) .
____________________
١ - المعجم الكبير ٣/١٠٧ مسند الحسين بن علي، ذكر مولده وصفته ح٢٨١٤، مجمع الزوائد ٩/١٨٨ كتاب المناقب: باب مناقب الحسين بن علي (عليهم السّلام)، كنز العمال ١٢/١٢٣ ح٣٤٢٩٩، فيض القدير ١/٢٦٦. وغيرها من المصادر.
٢ - مقتل الحسين - للخوارزمي ١/١٦٤ - ١٦٥ الفصل الثامن، واللفظ له، الفتوح - لابن أعثم ٤/٣٢٨ - ٣٣٠ ابتداء أخبار مقتل مسلم بن عقيل والحسين بن علي وولده.
٣ - المستدرك على الصحيحين ٣/١٧٩ كتاب معرفة الصحابة، أوّل فضائل أبي عبد الله الحسين بن علي الشهيد (رضي الله عنهم)، السلسلة الصحيحة ٣/٢٤٥ ح ١١٧١، مقتل الحسين - للخوارزمي ١/١٦٠ الفصل الثامن، إمتاع الأسماع - للمقريزي ١٢/٣٢٨، و١٤/١٤٥، وغيرها من المصادر.
٤ - الإرشاد ٢/١٣١ - ١٣٢، بحار الأنوار ٤٤/٢٦٣، ومثله في كشف الغمّة ٢/٢١٨ ولكن فيه (أصحاب محمد) بدل (أصحاب علي).
٥ - تاريخ دمشق ٤٥/٤٨ في ترجمة عمر بن سعد بن أبي وقّاص، واللفظ له، تهذيب الكمال ٢١/٣٥٩ في ترجمة عمر بن سعد بن أبي وقاص، تهذيب التهذيب ٧/٣٦٩ في ترجمة عمر بن سعد بن أبي وقّاص، تاريخ الإسلام - للذهبي ٥/١٩٥ في ترجمة عمر بن سعد بن أبي وقّاص، وغيرها من المصادر.
وقال ابن الأثير: قال عبد الله بن شريك: أدركت أصحاب الأردية المعلّمة، وأصحاب البرانس السود من أصحاب السواري إذا مرّ بهم عمر بن سعد قالوا: هذا قاتل الحسين، وذلك قبل أن يقتله(١) .
وروي أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال لعمر بن سعد: «كيف أنت إذا قمت مقاماً تخيّر فيه بين الجنّة والنار، فتختار النار؟!»(٢) .
وقال العريان بن الهيثم: كان أبي يتبدّى، فينزل قريباً من الموضع الذي كان فيه معركة الحسين. فكنّا لا نبدو إلّا وجدنا رجلاً من بني أسد هناك، فقال له: إنّي أراك ملازماً هذا المكان؟!
قال: بلغني أنّ حسيناً يُقتل هاهنا؛ فأنا أخرج لعلّي أصادفه فأُقتل معه.
فلمّا قُتل الحسين قال أبي: انطلقوا ننظر هل الأسدي فيمَنْ قُتل؟ وأتينا المعركة فطوّفنا فإذا الأسدي مقتول(٣) .
كما استفاض الحديث عن النبي وأهل بيته (صلوات الله عليهم أجمعين) وخواصّ أصحابهم - تبعاً لهم - عن انتقام الله (عزّ وجلّ) من قتلته من بعده.
فعن ابن عباس أنّه قال: «أوحى الله إلى نبيّكم صلى الله عليه وآله وسلم أنّي قتلت بيحيى سبعين ألفاً، وإنّي قاتل بابن ابنتك سبعين ألفاً وسبعين ألفاً»(٤) . ويأتي من الإمام الحسين
____________________
١ - الكامل في التاريخ ٤/٢٤٢ ذكر مقتل عمر بن سعد وغيره ممّن شهد قتل الحسين من أحداث سنة ٦٦ هـ، واللفظ له، ومثله في تاريخ دمشق ٤٥/٤٩ في ترجمة عمر بن سعد بن أبي وقّاص، وتهذيب الكمال ٢١/٣٥٩ في ترجمة عمر بن سعد بن أبي وقّاص.
٢ - تاريخ دمشق ٤٥/٤٩ في ترجمة عمر بن سعد بن أبي وقّاص، تهذيب الكمال ٢١/٣٥٩ في ترجمة عمر بن سعد بن أبي وقّاص، تاريخ الإسلام - للذهبي ٥/١٩٥ في ترجمة عمر بن سعد بن أبي وقّاص، الكامل في التاريخ ٤/٢٤٢ ذكر مقتل عمر بن سعد وغيره ممّنْ شهد قتل الحسين من أحداث سنة ٦٦ هـ، كنز العمال ١٣/٦٧٤ ح ٣٧٧٢٣.
٣ - تاريخ دمشق ١٤/٢١٦ - ٢١٧ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، واللفظ له. ترجمة الإمام الحسين (عليه السّلام) من طبقات ابن سعد/٥٠ ح ٢٨١، بغية الطلب في تاريخ حلب ٦/٢٦١٩.
٤ - المستدرك على الصحيحين ٢/٢٩٠ كتاب التفسير، تفسير سورة آل عمران، واللفظ له، وص ٥٩٢ كتاب تواريخ المتقدّمين من الأنبياء والمرسلين، ذكر يحيى بن زكريا نبي الله (عليهما السّلام)، ج: ٣ =
(صلوات الله عليه) التأكيد على ذلك.
الإخبار بنهضة المختار
وقال ميثم التمّار (رضوان الله عليه) - وهو من خواصّ أصحاب أمير المؤمنين (عليه السّلام) وحملة سرّه - للمختار بن أبي عبيدة الثقفي وهما في حبس ابن زياد قبل قتل الإمام الحسين (عليه السّلام): إنّك تفلت، وتخرج ثائراً بدم الحسين (عليه السّلام)، فتقتل هذا الجبّار الذي نحن في سجنه، وتطأ بقدمك هذا على جبهته وخديه(١) .
بل يبدو أنّ المختار قد أخذ منه، أو من غيره من أصحاب أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) أموراً وتفاصيل أكثر من ذلك؛ فقد قال ابن العرق مولى ثقيف:
«أقبلت من الحجاز حتى إذا كنت بالبسيطة من وراء واقصة استقبلت المختار بن أبي عبيدة خارجاً يريد الحجاز حين خلى سبيله ابن زياد، فلمّا استقبلته رحبّت به وعطفت إليه، فلمّا رأيت شَترَ عينه استرجعت له، وقلت له - بعدما توجّعت له -: ما بال عينك صرف الله عنك السوء؟ قال: خَبَط عيني ابن الزانية بالقضيب خبطة صارت إلى ما ترى. فقلت له: ما له شلّت أنامله؟ فقال المختار:
____________________
= /١٧٨ كتاب معرفة الصحابة (رضي الله عنهم)، فضائل الحسين بن علي (رضي الله عنهم)، وقال الحاكم بعد ذكر الحديث: هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه، سير أعلام النبلاء ٤/٣٤٢ في ترجمة سعيد بن جبير، قال الذهبي بعد ذكر الحديث: هذا حديث نظيف الإسناد منكر اللفظ، تاريخ دمشق ١٤/٢٢٥ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، وج ٦٤/٢١٦ في ترجمة يحيى بن سليمان بن نشوي، تهذيب الكمال ٦/٤٣١ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي، تاريخ بغداد ١/١٥٢ في ذكر سيدي شباب أهل الجنّة الحسن والحسين (عليهما السّلام)، فيض القدير ١/٢٦٥، تفسير القرطبي ١٠/٢١٩، الدرّ المنثور ٤/٢٦٤، كنز العمال ١٢/١٢٧ ح ٣٤٣٢٠، وغيرها من المصادر الكثيرة.
١ - شرح نهج البلاغة ٢/٢٩٣، واللفظ له، الإرشاد ١/٣٢٤، بحار الأنوار ٤٥/٣٥٣، وقريب منه في الإصابة ٦/٢٥٠ في ترجمة ميثم التمار الأسدي.
قتلني الله إن لم أقطع أنامله وأباجله(١) وأعضاءه إرباً إرباً».
قال: فعجّبت لمقالته، فقلت له: ما علمك بذلك رحمك الله؟! فقال لي: ما أقول لك فاحفظه عنّي حتى ترى مصداقه... يابن العرق، إنّ الفتنة قد أرعدت وأبرقت، وكأنّي قد انبعثت، فوطئت في خطامه، فإذا رأيتَ ذلك وسمعتَ به بمكان قد ظهرت فيه، فقيل: إنّ المختار في عصائبه من المسلمين يطلب بدم المظلوم الشهيد، المقتول بالطفّ سيّد المسلمين وابن سيّدها الحسين بن علي، فوربّك لأقتلنَّ بقتله عدّة القتلى التي قُتلت على دم يحيى بن زكريا (عليه السّلام).
قال: فقلت له: سبحان الله! وهذه أعجوبة مع الأحدوثة الأولى.
فقال: هو ما أقول لك، فاحفظه عنّي حتى ترى مصداقه.
ثمّ حرّك راحلته فمضى....
قال ابن العرق: فوالله، ما متّ حتى رأيت كلّ ما قاله(٢) ... إلى غير ذلك ممّا ورد عنه(٣) .
ولم يقتصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت (عليهم السّلام) على الإخبار بأصل الحدث، بل زادوا على ذلك بأمرين:
____________________
١ - الأباجل جمع الأبجل: وهو عرق غليظ في الرجل أو في اليد.
٢ - تاريخ الطبري ٤/٤٤٢ - ٤٤٣ أحداث سنة خمس وستين من الهجرة، مقدم المختار بن أبي عبيدة الكوفة، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/١٦٩ - ١٧٠ أحداث سنة أربع وستين من الهجرة، ذكر قدوم المختار الكوفة، الفتوح - لابن أعثم ٥/١٦٧ - ١٦٨ ذكر هرب المختار من ابن زياد وما كان من بيعته لعبد الله بن الزبير، وذكره مختصراًً باختلاف يسير في بحار الأنوار ٤٥/٣٥٣ - ٣٥٤، ونظير ذلك ما نقله الخوارزمي عن محمد بن إسحق صاحب السيرة من حديث المختار مع صقعب بن زهير في واقصة، مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/١٧٨ - ١٨٠ الفصل الخامس عشر في بيان انتقام المختار من قاتلي الحسين (عليه السّلام).
٣ - تاريخ الطبري ٤/٤٤٤ - ٤٥١ أحداث سنة خمس وستين من الهجرة، ذكر قدوم المختار الكوفة. وص ٤٧١ ما كان من أمر التوّابين وشخوصهم للطلب بدم الحسين بن علي إلى عبيد الله بن زياد، تاريخ اليعقوبي ٢/٢٥٨ أيام مروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير، الكامل في التاريخ ٤/١٧٠ - ١٧١، و١٧٣ ذكر قدوم المختار الكوفة، وص ١٨٦ ذكر مسير التوّابين وقتلهم.
بعض التفاصيل المناسبة لانتهاء النهضة بالفاجعة
الأوّل: بعض التفاصيل المناسبة لحصوله في هذه النهضة الشريفة، كتحديد
مكان قتله (عليه السّلام)(١) ، وزمانه(٢) ، وأنّ قاتله يزيد(٣) ، مع ذكر بعض مَنْ يشارك في
____________________
١ - وقد روي ذلك مسنداً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كلّ من مسند أحمد ١/٨٥ في مسند علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، ومجمع الزوائد ٩/١٨٧ - ١٩١ كتاب المناقب، باب مناقب الحسين بن علي (رضي الله عنهم)، والمصنّف - لابن أبي شيبة ٧/٢٧٦ كتاب الأمراء، ما ذكر من حديث الأمراء والدخول عليهم، وج ٨/٦٣٢ كتاب الفتن، من كره الخروج في الفتنة وتعوّذ عنه، ومسند أبي يعلى ١/٢٩٨ مسند علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، والمعجم الكبير ٣/١٠٦ - ١١١ مسند الحسين بن علي: ذكر مولده وصفته، وتاريخ دمشق ١٤/١٨٨ - ١٩٩ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، وتاريخ الإسلام ٥/١٠٢ - ١٠٣ في ترجمة الحسين بن علي (رضي الله عنه)، وسير أعلام النبلاء ٣/٢٨٩ في ترجمة الحسين الشهيد، والبداية والنهاية ٨/٢١٧ في أحداث سنة إحدى وستين، فصل بلا عنوان بعد ذكر صفة مقتله، والوافي بالوفيّات ١٢/٢٦٣ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب (رضي الله عنهم)، وإمتاع الأسماع ٨/١٢٩، وغيرها من المصادر الكثيرة جداً.
٢ - مثل ما روي مسنداً عن أُمّ سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يُقتل حسين على رأس ستين من مهاجري». المعجم الكبير ٣/١٠٥ مسند الحسين بن علي، ذكر مولده وصفته، واللفظ له، تاريخ بغداد ١/١٥٢ في ذكر مَنْ ورد بغداد من جلّة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحسين بن علي، تاريخ دمشق ١٤/١٩٨ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، مجمع الزوائد ٩/١٩٠ كتاب المناقب، باب مناقب الحسين بن علي (عليهم السّلام)، الفردوس بمأثور الخطاب ٥/٥٣٩، وغيرها من المصادر.
وكذا ما روي مسنداً عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يُقتل الحسين (عليه السّلام) حين يعلوه القتير». المعجم الكبير ٣/١٠٥ مسند الحسين بن علي، ذكر مولده وصفته، واللفظ له، مجمع الزوائد ٩/١٩٠ كتاب المناقب، باب مناقب الحسين بن علي (عليهم السّلام)، كنز العمّال ١٢/١٢٩ ح ٣٤٣٢٦، الفردوس بمأثور الخطاب ٥/٥٣٩.
٣ - الفتوح - لابن أعثم ٤/٣٢٨ ابتداء أخبار مقتل مسلم بن عقيل والحسين بن علي وولده، مقتل الحسين - للخوارزمي ١/١٦٣، المعجم الكبير ٣/١٢٠ مسند الحسين بن علي، ذكر مولده وصفته، وج ٢٠/٣٨ في ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص عن معاذ، مجمع الزوائد ٩/١٩٠ كتاب المناقب، باب مناقب الحسين بن علي (عليهم السّلام)، كنز العمّال ١١/١٦٦ ح ٣١٠٦١، وج ١٢/١٢٨ ح ٣٤٣٢٤، بحار الأنوار ٤٥/٣١٤، وغيرها من المصادر.
ذلك(١) ، وما يؤول إليه أمرهم - كما تقدّم بعضه - وغير ذلك ممّا قد يتّضح في تتمّة حديثنا هذا.
توقّع الإمام الحسين (عليه السّلام) أنّ عاقبة نهضته القتل
بل صرّح الإمام الحسين (عليه السّلام) نفسه ولوّح بأنّه يُقتل في هذه النهضة المقدّسة،
____________________
١ - بصائر الدرجات/٣١٨، إعلام الورى بأعلام الهدى ١/٣٤٥ الركن الثاني، في ذكر الإمام علي بن أبي طالب (عليه السّلام)، الباب الثالث، الآيات والدلالات المؤيّدة لإمامته، الإصابة ٢/٢٠٩ في ترجمة خالد بن عرفطة، شرح نهج البلاغة ٢/٢٨٧، وغيرها من المصادر.
ومن أمثلة ذلك ما رواه ابن أبي الحديد أنّه قال: روى ابن هلال الثقفي في كتاب الغارات، عن زكريا بن يحيى العطار، عن فضيل، عن محمد بن علي قال: لما قال علي (عليه السّلام): «سلوني قبل أن تفقدوني، فوالله لا تسألونني عن فئة تضلّ مئة وتهدي مئة إلّا أنبأتكم بناعقتها وسائقتها».
قام إليه رجل فقال: أخبرني بما في رأسي ولحيتي من طاقة شعر.
فقال له علي (عليه السّلام): «والله، لقد حدّثني خليلي أنّ على كلّ طاقة شعر من رأسك ملكاً يلعنك، وإنّ على كلّ طاقة شعر من لحيتك شيطاناً يغويك، وإنّ في بيتك سخلاً يقتل ابن رسول الله صلّى الله عليه وآله».
وكان ابنه قاتل الحسين (عليه السّلام) يومئذٍٍ طفلاً يحبو، وهو سنان بن أنس النخعي. شرح نهج البلاغة ٢/٢٨٦.
وروى أيضاً: أنّ تميم بن أسامة بن زهير بن دريد التميمي اعترضه وهو يخطب على المنبر ويقول: «سلوني قبل أن تفقدوني، فوالله لا تسألوني عن فئة تضلّ مئة، أو تهدي مئة إلّا نبأتكم بناعقها وسائقها. ولو شئت لأخبرت كلّ واحد منكم بمخرجه ومدخله وجميع شأنه».
فقال: فكم في رأسي طاقة شعر؟
فقال له: «أما والله، إنّي لأعلم ذلك، ولكن أين برهانه لو أخبرتك به، ولقد أخبرتك [كذا في المصدر] بقيامك ومقالك. وقيل لي: إنّ على كلّ شعرة من شعر رأسك ملكاً يلعنك وشيطاناً يستفزّك، وآية ذلك أنّ في بيتك سخلاً يقتل ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحضّ على قتله».
فكان الأمر بموجب ما أخبر به (عليه السّلام)، كان ابنه حصين - بالصاد المهملة - يومئذٍ طفلاً صغيراً يرضع اللبن، ثمّ عاش إلى أن صار على شرطة عبيد الله بن زياد، وأخرجه عبيد الله إلى عمر بن سعد يأمره بمناجزة الحسين (عليه السّلام) ويتوعّده على لسانه إنْ أرجأ ذلك، فقُتل (عليه السّلام) صبيحة اليوم الذي ورد فيه الحصين بالرسالة في ليلته. ج١٠/١٤ - ١٥.
كما يأتي في خطبته (عليه السّلام) في مكّة حينما أراد الخروج إلى العراق.
وعن الإمام علي بن الحسين زين العابدين (عليه السّلام) قال: «خرجنا مع الحسين (عليه السّلام) فما نزل منزلاً ولا ارتحل منه إلّا ذكر يحيى بن زكريا وقتله. وقال يوماً: ومن هوان الدنيا على الله أنّ رأس يحيى بن زكريا (عليه السّلام) أُهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل»(١) .
ونحوه حديث الإمام الحسين (عليه السّلام) مع عبد الله بن عمر(٢) .
ففي حديث له مع بعض مَنْ لقيه في الطريق قال فيه: «هذه كتب أهل الكوفة إليّ، ولا أراهم إلّا قاتلي...»(٣) .
وفي حديث له مع أبي هرّة الأزدي: «يا أبا هرّة، لتقتلني الفئة الباغية، وليلبسنّهم الله تعالى ذلاً شاملاً، وسيفاً قاطعاً...»(٤) .
وقد سبق منه (عليه السّلام) تأكيده لعمر بن سعد صدق ما يتحدّث به الناس من أنّه سيقتله، وأنّه من بعده (عليه السّلام) لا يأكل من برّ العراق إلّا قليلاً، وكرّر (عليه السّلام) التنبؤ له بقلّة بقائه بعده قبل المعركة بأيام(٥) .
____________________
١ - الإرشاد ٢/١٣٢، إعلام الورى بأعلام الهدى ١/٤٢٩، مناقب آل أبي طالب - لابن شهر آشوب ٣/٢٣٧، بحار الأنوار ١٤/١٧٥، وج ٤٥/٩٠، ٢٩٨.
٢ - الفتوح - لابن أعثم ٥/٢٨ وصية الحسين (رضي الله عنه) لأخيه محمد (رضي الله عنه)، مقتل الحسين - للخوارزمي ١/١٩٢ الفصل العاشر.
٣ - تاريخ دمشق ١٤/٢١٦ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، واللفظ له، سير أعلام النبلاء ٣/٣٠٦ في ترجمة الحسين الشهيد، تاريخ الإسلام ٥/١٢ الطبقة السابعة، حوادث سنة واحد وستين، مقتل الحسين، البداية والنهاية ٨/١٨٣ أحداث سنة ستين من الهجرة، صفة مخرج الحسين إلى العراق، ترجمة الإمام الحسين (عليه السّلام) من طبقات ابن سعد/٦٤ ح ٢٩٠، نظم درر السمطين/٢١٤، وغيرها من المصادر.
٤ - مقتل الحسين - للخوارزمي ١/٢٢٦ الفصل الحادي عشر في خروج الحسين من مكة إلى العراق، واللفظ له، الفتوح - لابن أعثم ٥/٧٩ ذكر مسير الحسين (رضي الله عنه) إلى العراق، اللهوف في قتلى الطفوف/٤٣ - ٤٤ خروج الحسين من مكة إلى العراق، وغيرها من المصادر.
٥ - تاريخ دمشق ٤٥/٤٨ في ترجمة عمر بن سعد بن أبي وقاص، تهذيب الكمال ٢١/٣٥٩ في ترجمة عمر بن سعد بن أبي وقاص، تهذيب التهذيب ٧/٣٩٦ في ترجمة عمر بن سعد بن أبي وقاص، تاريخ الإسلام ٥/١٩٥ في ترجمة عمر بن سعد بن أبي =
وقال له يوم عاشوراء قُبيل المعركة: «أما والله يا عمر، ليكوننّ لما ترى يوم يسوؤك»(١) .
وقال له أيضاً: «يا عمر، أنت تقتلني وتزعم أن يولّيك الدعي ابن الدعي بلاد الرّي وجرجان! والله لا تتهنأ بذلك أبداً؛ عهد معهود. فاصنع ما أنت صانع؛ فإنّك لا تفرح بعدي بدنيا ولا آخرة، وكأنّي برأسك على قصبة قد نُصب بالكوفة يتراماه الصبيان ويتّخذونه غرضاً بينهم»(٢) .
كما خطب (صلوات الله عليه) عسكر ابن سعد لما رأى منهم التصميم على قتاله، فقال في آخر خطبته: «ثمّ أيم الله لا تلبثون بعدها إلّا كريثما يُركب الفرس، ثمّ تدور بكم دور الرحى، وتقلق بكم قلق المحور، عهد عهده إليّ أبي عن جدّي،( فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً... ) »(٣) .
وقال (عليه السّلام) في دعائه عليهم: «اللّهمّ احبس عنهم قطر السماء، وابعث عليهم سنين كسني يوسف، وسلّط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأساً مصبّرة...(٤) ، ولا يدع فيهم أحداً إلّا قتله، قتلة بقتلة، وضربة بضربة، ينتقم لي ولأوليائي وأهل بيتي وأشياعي منهم»(٥) ، إلى غير ذلك.
____________________
= وقاص، الفتوح - لابن أعثم ٥/١٠٣ ذكر اجتماع العسكر إلى حرب الحسين بن علي (رضي الله عنه)، مقتل الحسين - للخوارزمي ١/٢٤٥ الفصل الحادي عشر في خروج الحسين من مكة إلى العراق، وغيرها من المصادر.
١ - ترجمة الإمام الحسين (عليه السّلام) من طبقات ابن سعد/٧٢ ح ٢٩٢، واللفظ له، سير أعلام النبلاء ٣/٣٠٢ في ترجمة الحسين الشهيد.
٢ - مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٨، واللفظ له، بحار الأنوار ٤٥/١٠.
٣ - اللهوف في قتلى الطفوف/٥٩، واللفظ له، تاريخ دمشق ١٤/٢١٩ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٧، كفاية الطالب/٤٢٩.
٤ - مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٨، واللفظ له، اللهوف في قتلى الطفوف/٦٠.
٥ - بحار الأنوار ٤٥/١٠، واللفظ له. العوالم/٢٥٣.
الحثّ على نصر الإمام الحسين (عليه السّلام) والتأنيب على خذلانه
الثاني: الحثّ على نصر الإمام الحسين (عليه السّلام)، والتأنيب على خذلانه، مثل ما تقدّم في خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما عن أنس بن الحرث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إنّ ابني هذا - يعني الحسين - يُقتل بأرض يُقال لها كربلاء، فمَنْ شهد ذلك منكم فلينصره»(١) .
وعن زهير بن القين قال: غزونا بلنجر ففتح علينا، وأصبنا غنائم ففرحنَ، وكان معنا سلمان الفارسي فقال لنا: إذا أدركتم سيّد شباب أهل محمد [الجنّة] فكونوا أشدّ فرحاً بقتالكم معه بما أصبتم اليوم من الغنائم(٢) .
وفي حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أخبر بقتل الحسين (عليه السّلام) قال: «والذي نفسي بيده، لا يُقتل بين ظهراني قوم لا يمنعوه إلّا خالف الله بين صدورهم وقلوبهم، وسلّط عليهم شرارهم، وألبسهم شيعاً...»(٣) .
____________________
١ - تاريخ دمشق ١٤/٢٢٤ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، واللفظ له، الإصابة ١/٢٧١ في ترجمة أنس بن الحارث بن نبيه، أسد الغابة ١/١٢٣ في ترجمة أنس بن الحارث، البداية والنهاية ٨/٢١٧ في أحداث سنة إحدى وستين، فصل بلا عنوان بعد ذكر صفة مقتله، إمتاع الأسماع ١٢/٢٤٠، و١٤/١٤٨ إنذاره صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الحسين بن علي بن أبي طالب (رضي الله عنهم)، ذخائر العقبى/١٤٦، ينابيع المودّة ٣/٨،٥٢، كنز العمال ١٢/١٢٦ ح ٣٤٣١٤، بحار الأنوار ١٨/١٤١، و٤٤/٢٤٧، وغيرها من المصادر.
٢ - الكامل في التاريخ ٤/٤٢ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر مسير الحسين إلى الكوفة، واللفظ له، تاريخ الطبري ٤/٢٩٩ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مسير الحسين (عليه السّلام) من مكة متوجهاً إلى الكوفة وما كان من أمره في مسيره، معجم ما استعجم ١/٢٧٦ في مادة (بلنجر)، مقتل الحسين - للخوارزمي ١/٢٢٥ الفصل الحادي عشر في خروج الحسين من مكة إلى العراق.
٣ - المعجم الكبير ٣/١٢٠ مسند الحسين بن علي: ذكر مولده وصفته، و٢٠/٣٩ في ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص عن معاذ، واللفظ له، مجمع الزوائد ٩/١٩٠ كتاب المناقب، باب مناقب الحسين بن علي (عليهم السّلام)، كنز العمال ١١/١٦٦ ح ٣١٠٦١، مقتل الحسين - للخوارزمي ١/١٦١ الفصل الثامن في إخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسين وأحواله، وغيرها من المصادر.
وقال أمير المؤمنين (عليه السّلام) للبراء بن عازب: «يا براء، أيقتل الحسين وأنت حي فلا تنصره؟!».
فقال البراء: لا كان ذلك يا أمير المؤمنين.
فلمّا قُتل الحسين (عليه السّلام) كان البراء يذكر ذلك، ويقول: أعظم بها حسرة؛ إذ لم أشهده، وأُقتل دونه(١) .
الإمام الحسين (عليه السّلام) مأمور بنهضته عالم بمصيره
وذلك بمجموعه يكشف عن أنّه (صلوات الله عليه) قد أقدم على تلك النهضة عالماً بمصيره، وأنّه (عليه السّلام) كان مأموراً بنهضته من قِبَل الله تعالى، وإلاّ فلو لم يكن ذلك مرضيّاً لله تعالى لكان على النبي وأمير المؤمنين (صلوات الله عليهما وآلهما) تحذيره من مغبّة نهضته ومنعه منه، لا حثّ الناس على نصره وتأنيبهم على خذلانه، ولو كانا قد حذّراه ومنعاه لكان حريّاً بالاستجابة لهم؛ فإنّه (صلوات الله عليه) أتقى لله تعالى من أن يتعمّد خلافهم.
بل ورد عنهما (صلوات الله عليهما وآلهما) أنّهما حثّاه ورغّباه، فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال للإمام الحسين (عليه السّلام): «إنّ لك في الجنّة درجة لا تنالها إلّا بالشهادة»(٢) .
كما ورد أنّه صلى الله عليه وآله وسلم أخبره بذلك في الرؤيا لما قرب الموعد(٣) .
وعن أمير المؤمنين (عليه السّلام) أنّه لما حاذى نينوى في طريقه إلى صفين نادى:
____________________
١ - شرح نهج البلاغة ١٠/١٥، واللفظ له، الإرشاد ١/٣٣١، إعلام الورى بأعلام الهدى ١/٣٤٥، مناقب آل أبي طالب - لابن شهرآشوب ٢/١٠٦، بحار الأنوار ٤٤/٢٦٢، وغيرها من المصادر.
٢ - مقتل الحسين - للخوارزمي ١/١٧٠ الفصل الثامن في إخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسين وأحواله.
٣ - راجع الفتوح - لابن أعثم ٥/٢٠ ذكر كتاب يزيد بن معاوية إلى الوليد بن عتبة، مقتل الحسين - للخوارزمي ١/١٨٧ الفصل التاسع في بيان ما جرى بينه وبين الوليد بن عتبة ومروان بن الحكم بالمدينة في حياة معاوية وبعد وفاته، ينابيع المودّة ٣/٥٤، الأمالي - للصدوق/٢١٧، بحار الأنوار ٤٤/٣١٣، ٣٢٨، و٥٨/١٨٢.
«صبراً أبا عبد الله، صبراً أبا عبد الله»، ثمّ ذكر مقتله بشطّ الفرات(١) ... إلى غير ذلك ممّا رواه الفريقان خصوصاً شيعة أهل البيت (عليهم السّلام).
كما أنّ الإمام الحسين (صلوات الله عليه) صرّح برضى الله تعالى بنهضته، وأنّ الله تعالى قد اختارها له في خطبته العظيمة في مكّة المكرّمة حين عزم على الخروج منها متوجّهاً إلى العراق، حيث قال فيها في جملة ما قال: «خطّ الموت على ولد آدم مخطّ القلادة على جيد الفتاة. وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. وخِيرَ لي مصرع أنا لاقيه. كأنّي بأوصالي هذه تقطّعها عسلان الفلاة بين النواويس وكربلاء... لا محيص عن يوم خطّ بالقلم. رضى الله رضانا أهل البيت. نصبر على بلائه ويوفّينا أجور الصابرين... مَنْ كان فينا باذلاً مهجته، وموطّناً على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا؛ فإنّي راحل مصبحاً إن شاء الله تعالى»(٢) .
كما يأتي عنه (عليه السّلام) أنّه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمره بأمر هو ماضٍ فيه، كان له أو عليه، بل أنّه صلى الله عليه وآله وسلم أخبره في الرؤيا بأنّه سوف يُقتل.
ويؤيّد ذلك أمران:
____________________
١ - مصنّف ابن أبي شيبة ٨/٦٣٢ كتاب الفتن، من كره الخروج في الفتنة وتعوّذ عنه، المعجم الكبير ٣/١٠٥ مسند الحسين بن علي، ذكر مولده وصفته، الآحاد والمثاني ١/٣٠٨، تاريخ دمشق ١٤/١٨٧ - ١٨٨ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، تهذيب الكمال ٦/٤٠٧ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، تهذيب التهذيب ٢/٣٠٠ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، تاريخ الإسلام ٥/١٠٢ في ترجمة الحسين بن علي (رضي الله عنه)، إمتاع الأسماع ١٢/٢٣٦ إنذاره صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الحسين بن علي بن أبي طالب (رضي الله عنهم)، ترجمة الحسين (عليه السّلام) من طبقات ابن سعد/٤٨ ح ٢٧٤، ذخائر العقبى/١٤٨ ذكر إخبار الملك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الحسين وإيرائه تربة الأرض التي يُقتل به، وغيرها من المصادر الكثيرة.
٢ - اللهوف في قتلى الطفوف/٣٨، واللفظ له، مثير الأحزان/٢٠، مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٥ - ٦. وقد روى الخطبة بسنده عن الإمام زين العابدين (عليه السّلام).
الشواهد على أنّه (عليه السّلام) لم يتحرّ مظان السلامة
الأوّل: إنّه يوجد في بعض زوايا التاريخ ما يشهد بأنّه (صلوات الله عليه) لم يكن في مقام تحرّي مظان السلامة، بل كان مصرّاً على السير في طريقه إلى مصرعه الذي يعرفه، وحيث انتهى وقُتل.
فهو (عليه السّلام) وإن كان يؤكّد على الحذر من أن يُقتل في مكّة المكرّمة؛ لئلاّ يكون هو الذي تُنتهك به حرمتها، إلّا أنّه لم يعرج على ما أشار به غير واحد - كما يأتي - من الذهاب إلى اليمن، ولم يناقش وجهة نظرهم، بل توجّه للعراق.
وفي أوّل الطريق لقيه الفرزدق فسأله (عليه السّلام) عن خبر الناس فقال: الخبير سألت، قلوب الناس معك، وسيوفهم مع بني أُميّة، والقضاء ينزل من السماء، والله يفعل ما يشاء.
فقال (صلوات الله عليه): «صدقت. لله الأمر يفعل ما يشاء، وكلّ يوم ربّنا في شأن. إنْ نزل القضاء بما نحبّ فنحمد الله على نعمائه، وهو المستعان على أداء الشكر، وإنْ حال القضاء دون الرجاء فلم يعتدِ مَنْ كان الحقّ نيّته، والتقوى سريرته»(١) .
ولم يحمله ذلك على أن يُعيد النظر في أمره، ويراجع حساباته، ويتلبّث حتى تنجلي الأمور، ويتّضح موقف الناس، وموقف شيعته - الذين كاتبوه - بعد ولاية ابن زياد على الكوفة، واستلامه السلطة فيه.
____________________
١ - تاريخ الطبري ٤/٢٩٠ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مسير الحسين (عليه السّلام) من مكة متوجّهاً إلى الكوفة وما كان من أمره في مسيره، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/٤٠ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر مسير الحسين (عليه السّلام) إلى الكوفة، البداية والنهاية ٨/١٨٠ أحداث سنة ستين من الهجرة، صفة مخرج الحسين إلى العراق، الفتوح - لابن أعثم ٥/٨٠ ذكر مسير الحسين (رضي الله عنه) إلى العراق، الإرشاد ٢/٦٧، مقتل الحسين - للخوارزمي ١/٢٢٣ الفصل الحادي عشر في خروج الحسين من مكة إلى العراق، وغيرها من المصادر.
وحتى بعد أن بلغه - قبل التقائه بالحرّ وأصحابه - خذلان الناس له، ومقتل مسلم بن عقيل (عليه السّلام) وهاني بن عروة وعبد الله بن يقطر (رضي الله عنهم)، وإحكام ابن زياد سيطرته على الكوفة لم يثنه ذلك عن المضي في طريقه.
كما ورد أنّه لما بلغه مقتل مسلم بن عقيل (عليه السّلام) وهاني بن عروة استرجع وترحّم عليهما مراراً وبكى(١) ، وبكى معه الهاشميون، وكثر صراخ النساء حتى ارتجّ الموضع لقتل مسلم، وسالت الدموع كلّ مسيل(٢) .
وقال (صلوات الله عليه): «رحم الله مسلم، فلقد صار إلى روح الله وريحانه، وتحيّته وغفرانه ورضوانه، أما إنّه قد قضى ما عليه وبقي ما علينا»(٣) .
بل لما وصلته (عليه السّلام) رسالة ابن الأشعث يخبره عن لسان مسلم بن عقيل بما آل إليه أمره، ويطلب منه الرجوع، لم يزد على أن قال: «كلّ ما حمّ نازل، وعند الله نحتسب أنفسنا وفساد أُمّتنا»(٤) ، واستمر في سيره.
____________________
١ - تاريخ الطبري ٤/٢٩٩ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مسير الحسين (عليه السّلام) من مكّة متوجّهاً إلى الكوفة....
٢ - اللهوف في قتلى الطفوف/٤٥.
٣ - مقتل الحسين - للخوارزمي ١/٢٢٣ الفصل الحادي عشر في خروج الحسين من مكة إلى العراق، واللفظ له، الفتوح - لابن أعثم ٥/٨٠ ذكر مسير الحسين (رضي الله عنه) إلى العراق، الفصول المهمّة ٢/٧٧٣ الفصل الثالث في ذكر الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام)، فصل في ذكر شيء من محاسن كلامه وبديع نظامه (عليه السّلام)، مطالب السؤول في مناقب آل الرسول/٣٩٠ الفصل الثامن في كلامه (عليه السّلام)، اللهوف في قتلى الطفوف/٤٥ خروج الحسين من مكة إلى العراق، وغيرها من المصادر.
٤ - تاريخ الطبري ٤/٢٩٠ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين (عليه السّلام) للمسير إلى ما قبلهم وأمر مسلم بن عقيل، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/٣٣ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين بن علي ليسير إليهم وقتل مسلم بن عقيل، البداية والنهاية ٨/١٧١ أحداث سنة ستين من الهجرة، قصّة الحسين بن علي وسبب خروجه من مكة في طلب الإمارة ومقتله، وغيرها من المصادر.
إخبار الإمام الحسين (عليه السّلام) لمَنْ معه بخذلان الناس له
غاية الأمر أنّه (عليه السّلام) أعلم بذلك في الطريق مَنْ كان معه من الناس قبل أن يلتقي بالحرّ وأصحابه.
قال بكر بن مصعب المزني: كان الحسين لا يمرّ بأهل ماء إلّا اتّبعوه حتى انتهى إلى زبالة سقط إليه مقتل أخيه من الرضاعة مقتل عبد الله بن بقطر... فأخرج للناس كتاباً فقرأ عليهم: «بسم الله الرحمن الرحيم. أمّا بعد؛ فإنّه قد أتانا خبر فظيع. قتل مسلم بن عقيل، وهانئ بن عروة، وعبد الله بن بقطر، وقد خذلتنا شيعتنا، فمَنْ أحب منكم الانصراف فلينصرف ليس عليه منّا ذمام».
قال: فتفرّق الناس عنه تفرّقاً، فأخذوا يميناً وشمالاً حتى بقي في أصحابه الذين جاؤوا معه من المدينة. وإنّما فعل ذلك؛ لأنّه ظنّ إنّما اتّبعه الأعراب لأنّهم ظنّوا أنّه يأتي بلداً قد استقامت له طاعة أهله، فكره أن يسيروا معه إلّا وهم يعلمون على مَ يقدمون، وقد عَلِم أنّهم إذا بيّن لهم لم يصحبه إلّا مَنْ يريد مواساته والموت معه(١) .
تهيؤ الإمام الحسين (عليه السّلام) للقاء الحرّ وأصحابه
وفي حديث عبد الله بن سليم والمذري بن المشمعل الأسديين أنّ الإمام الحسين (عليه السّلام) نزل شراف، فلمّا كان في السحر أمر فتيانه فاستقوا من الماء فأكثروا، ثمّ سار حتى انتصف النهار، ثمّ التقى بالحرّ ومَنْ معه - وهم ألف فارس - في حرّ الظهيرة، فقال (صلوات الله عليه) لفتيانه: «اسقوا القوم، وارووهم من الماء،
____________________
١ - تاريخ الطبري ٤/٣٠٠ - ٣٠١ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/٤٣ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر مسير الحسين إلى الكوفة، الإرشاد ٢/٧٥ - ٧٦.
ورشّفوا الخيل ترشيفاً».
قالا: فقام فتيانه فرشّفوا الخيل ترشيفاً، فقام فتية وسقوا القوم من الماء حتى أرووهم، وأقبلوا يملؤون القصاع والأتوار والطساس من الماء ثمّ يدنونها من الفرس، فإذا عبّ فيه ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً عزلت عنه وسقوا آخر حتى سقوا الخيل كلّها(١) .
ويظهر من ذلك أنّه (عليه السّلام) قد تهيّأ للقاء الحرّ وجيشه من السحر حينما أمر باستقاء الماء فأكثروا منه، وإلاّ فركب الإمام الحسين (صلوات الله عليه) يقارب المئتين أو يزيد عليها قليلاً، وليس من الطبيعي أن يستقي من الماء ما يفيض عن حاجته بمقدار ما يكفي لإرواء ذلك الجيش البالغ ألف نفر وإرواء خيلهم لو لم يكن (عليه السّلام) قد تهيّأ لذلك، وتعمّد الزيادة من الماء سحراً قبل ارتحاله من شراف.
وإذا كان (عليه السّلام) عالماً بلقاء ذلك الجيش فمن الطبيعي أن يكون عالماً بنتائج ذلك اللقاء وما يترتّب عليه، وموطّناً نفسه عليه، من أجل تحقيق هدفه، وإلاّ كان بوسعه الرجوع قبل لقائه.
وبذلك يظهر أنّ محاولته (صلوات الله عليه) بعد لقاء ذلك الجيش الرجوع(٢) ليس لاحتمال فسح المجال له، وقبولهم بذلك في محاولة للتراجع عن مقصده بعد أن ظهر له خطأ تقديره وحساباته، بل هو أشبه بطلب صوري إقامة للحجّة، ومقدّمة لاتفاقه مع الحرّ على أن يسير في طريق لا يوصله للكوفة ولا يردّه للمدينة، بل ينتهي به إلى حيث انتهى، وقد تحقّق له (عليه السّلام) ما أقدم عليه.
____________________
١ - تاريخ الطبري ٤/٣٠٢ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، واللفظ له، الإرشاد ٢/٧٦ - ٧٧، وقد رواه مختصراً ابن الأثير في الكامل في التاريخ ٤/٤٦ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه).
٢ - تاريخ الطبري ٤/٣٠٣ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، الكامل في التاريخ ٤/٤٧ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه).
اتفاقه (عليه السّلام) مع الحرّ في الطريق
ولمّا التقى (صلوات الله عليه) بالحرّ بن يزيد الرياحي - الذي بعثه ابن زياد في ألف رجل ليأتوه بالحسين إلى الكوفة - كان (عليه السّلام) في أبعد موضع عن نفوذ ابن زياد، وأصعب مكان لتجمّع الجيش ضدّه، حيث لا ماء ولا زرع، ولا قِرى ولا مأوى.
لكنّه (عليه السّلام) بعد أن منعه الحرّ من الرجوع اتّفق مع الحرّ - كما سبق - على أن يسلك طريقاً لا يوصله للكوفة ولا يرجع به للمدينة، واستمر في السير في منطقة نفوذ ابن زياد، وتوغّل فيه.
مع أنّه (صلوات الله عليه) إن كان آيساً من نصرة أهل الكوفة له كان الأصلح له عسكرياً أن يقف حيث انتهى، أو يقتصر في السير على أوّل موضع يجد فيه الماء.
وإن كان يأمل نصرتهم، ويحاول الحصول عليه، كان الأصلح له أن يسير مع الحرّ إلى مشارف الكوفة، ثمّ يمتنع من الاستسلام لابن زياد ويستنصر الناس، حيث يسهل على مَنْ يريد نصره من الكوفيين أن يصل إليه ويلتحق به.
بينما يتعذّر ذلك على الكثير منهم إذا بعد عن الكوفة؛ لأنّ عبيد الله بن زياد يستطيع حينئذ محاصرة الكوفة وضبط أطرافها، بحيث يتعذّر على مَنْ يعرف بالتشيّع الوصول للإمام الحسين (عليه السّلام).
وفعلاً قام ابن زياد بذلك. قال ابن سعد: وجعل الرجل والرجلان والثلاثة يتسلّلون إلى حسين من الكوفة، فبلغ ذلك عبيد الله فخرج فعسكر بالنخيلة، واستعمل على الكوفة عمرو بن حريث، وأخذ الناس بالخروج إلى النخيلة، وضبط الجسر فلم يترك أحداً يجوزه(١) .
____________________
١ - ترجمة الحسين (عليه السّلام) من طبقات ابن سعد/٦٩ - ٧٠ ح ٢٩٠، واللفظ له، سير أعلام النبلاء ٣/٣٠٠ في ترجمة الحسين الشهيد، أنساب الأشراف ٣/٣٨٨ خروج الحسين بن علي من مكة إلى الكوفة، وغيرها من المصادر.
امتناعه (عليه السّلام) من الذهاب لجبل طيء
كما إنّه (صلوات الله عليه) في الطريق بعد لقائه مع الحرّ التقى بالطرماح بن عدي الطائي، فذكر له الطرماح أنّه رأى الناس قد جُمعوا من أجل أن يُسرَّحوا لقتاله. وقال له: فإن أردت أن تنزل بلداً يمنعك الله به حتى ترى من رأيك، ويستبين لك ما أنت صانع، فسر حتى أنزلك مناع جبلنا الذي يدعى (أج)، امتنعنا والله به من ملوك غسّان وحمير، ومن النعمان بن المنذر، ومن الأسود والأحمر. والله، إن دخل علينا ذلّ قطّ. فأسير معك حتى أُنزلك القرية، ثمّ نبعث إلى الرجال ممّن بأجأ وسلمى من طيء. فوالله، لا يأتي عليك عشرة أيام حتى يأتيك طيء رجالاً وركبان. ثمّ أقم فينا ما بدا لك. فإن هاجك هيج فأنا زعيم لك بعشرين ألف طائي يضربون بين يديك بأسيافهم. والله، لا يوصَل إليك أبداً ومنهم عين تطرف.
فجزاه الإمام الحسين (عليه السّلام) وقومه خيراً، وقال: «إنّه قد كان بيننا وبين هؤلاء القوم قول لسنا نقدر معه على الانصراف، ولا ندري علامَ تنصرف بنا وبهم الأمور في عاقبة»(١) .
وأخيراً كانت نتيجة اتّفاقه (عليه السّلام) مع الحرّ أن وصل إلى مكان بعيد عن الكوفة قريب من نهر الفرات، حيث الماء والزرع والقرى، وحيث يسهل تجمّع الجيوش لقتاله، ويصعب أو يتعذّر على مَنْ يريد نصره الوصول إليه.
____________________
١ - تاريخ الطبري ٤/٣٠٧ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/٥٠ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، البداية والنهاية ٨/١٨٨ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، صفة مقتله مأخوذة من كلام أئمّة الشأن، ومثله مختصراً في أنساب الأشراف ٣/٣٨٣ خروج الحسين بن علي من مكة إلى الكوفة، وغيرها من المصادر.
ثمّ لما وصل كتاب ابن زياد للحرّ يأمره أن يجعجع بالحسين (عليه السّلام) وأصحابه، وينزلهم على غير ماء ولا في قرية، قالوا له: دعنا ننزل نينوى أو الغاضريات أو شفية، فمنعهم؛ معتذراً بأنّ رسول ابن زياد عين عليه.
فقال زهير بن القين (رضي الله عنه) للإمام الحسين (صلوات الله عليه): يابن رسول الله، إنّ قتال هؤلاء أهون من قتال مَنْ يأتينا من بعدهم. فلعمري، ليأتينا من بعد مَنْ ترى ما لا قِبَل لنا به.
فقال (عليه السّلام): «ما كنت لأبدأهم بالقتال»(١) .
مع إنّه (صلوات الله عليه) لو أصرّ على النزول في إحدى القرى الحصينة، فإن تركوه فذاك، وإن قاتلوه كانوا هم البادئين بالقتال لا هو (عليه السّلام)، لكنّه استجاب لهم ولم يُمانع.
تصريحه (عليه السّلام) حين وصوله كربلاء بما عُهد إليه
حتى إذا نزل في الموضع الذي قُتل فيه قال: «ههنا مناخ ركابنا، ومحطّ رحالنا، ومسفك دمائنا»(٢) .
وزاد ابن طاووس: «بهذا حدّثني جدّي رسول الله صلّى الله عليه وآله»(٣) .
____________________
١ - تاريخ الطبري ٤/٣٠٩ في أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/٥٢ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، الفتوح - لابن أعثم ٥/٩٠ ذكر الحرّ بن يزيد الرياحي لما بعثه عبيد الله بن زياد لحربه الحسين بن علي (رضي الله عنهم)، الأخبار الطوال/٢٥٢ خروج الحسين إلى الكوفة، إعلام الورى بأعلام الهدى ١/٤٥١، وغيرها من المصادر.
٢ - مقتل الحسين - للخوارزمي ١/٢٣٧ الفصل الحادي عشر في خروج الحسين من مكة إلى العراق، واللفظ له، الفتوح - لابن أعثم ٥/٩٤ ذكر نزول الحسين (رضي الله عنه) بكربلاء، مطالب السؤول في مناقب آل الرسول/٤٠٠، الفصول المهمّة ٢/٨١٦ الفصل الثالث في ذكر الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام)، فصل في ذكر مصرعه ومدّة عمره وإمامته (عليه السّلام)، مناقب آل أبي طالب - لابن شهرآشوب ٣/٢٤٧، اللهوف في قتلى الطفوف/٤٩ وصول الحسين إلى كربلاء، وغيرها من المصادر.
٣ - اللهوف في قتلى الطفوف/٤٩ وصول الحسين إلى كربلاء.
وقال سبط ابن الجوزي: فلمّا قيل للحسين: هذه أرض كربلاء، شمّها، وقال: «هذه والله هي الأرض التي أخبر بها جبرئيل رسول الله، وأنّني أُقتل فيها»(١) .
وقال الدينوري: قال الحسين: «وما اسم هذا المكان؟».
قالوا له: كربلاء.
قال: «ذات كرب وبلاء. ولقد مرّ أبي بهذا المكان عند مسيره إلى صفين وأنا معه، فوقف فسأل عنه، فأُخبرنا باسمه. فقال: ههنا محطّ ركابهم، وههنا مهراق دمائهم. فسُئل عن ذلك، فقال: ثقل لآل بيت محمد ينزلون ههنا»(٢) .
وروى جابر بسند معتبر عن الإمام الباقر (عليه السّلام) قال: «قال الحسين (عليه السّلام) لأصحابه قبل أن يُقتل: إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لي: يا بُني، إنّك ستُساق إلى العراق، وهي أرض قد التقى بها النبيّون وأوصياء النبيّين، وهي أرض تُدعى عمّور، وإنّك تستشهد به، ويستشهد جماعة من أصحابك...»(٣) ... إلى غير ذلك.
تنبيهه (عليه السّلام) لظلامته وتمسّكه بموقفه
وبعد أن انتهى (صلوات الله عليه) إلى حيث يريد حاول أن يلفت النظر لظلامته؛ ليستثير العواطف، وأن يؤكّد على تمسّكه بموقفه وشرف هدفه، إقامة للحجّة.
فقد جمع (عليه السّلام) ولده وإخوته وأهل بيته، ونظر إليهم وبكى، وقال: «اللّهمّ إنّا عترة نبيّك محمد صلواتك عليه قد أُخرجنا وأُزعجنا وطُردنا عن حرم جدنا،
____________________
١ - تذكرة الخواص/٢٥٠ الباب التاسع في ذكر الحسين (عليه السّلام)، ذكر مقتله (عليه السّلام).
٢ - الأخبار الطوال/٢٥٣ خروج الحسين إلى الكوفة، واللفظ له، تاريخ الخميس ٢/٢٩٧ - ٢٩٨ الفصل الثاني في ذكر الخلفاء الراشدين وخلفاء بني أُميّة والعباسيين، ذكر مقتل الحسين بن علي وأين قُتل ومَنْ قتله، حياة الحيوان ١/١١١ في كلامه عن (الأوز).
٣ - الخراج والجرائح ٢/٨٤٨، واللفظ له، بحار الأنوار ٥٣/٦١ - ٦٢.
وتعدّت بنو أُميّة علينا. اللّهمّ فخذ لنا بحقنا، وانصرنا على القوم الظالمين»(١) .
ثمّ أقبل على أصحابه فقال: «الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درّت معايشهم، فإذا محّصوا بالبلاء قلّ الديانون»(٢) .
ثمّ حمد الله وأثنى عليه، وصلّى على النبي وآله وقال: «إنّه قد نزل بنا من الأمر ما قد ترون، وإنّ الدنيا قد تغيّرت وتنكّرت، وأدبر معروفها، واستمرت حذاء، ولم تبقَ منها إلّا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون إلى الحقّ لا يُعمل به، وإلى الباطل لا يُتناهى عنه؟ ليرغب المؤمن في لقاء ربّه محقّاً؛ فإنّي لا أرى الموت إلّا سعادة، والحياة مع الظالمين إلّا برماً»(٣) .
فإنّ ملاحظة هذه الأمور بموضوعية وإنصاف تشهد بتصميمه (صلوات الله عليه) على أن يصل إلى موضع مصرعه الذي وعِد به، وعدم تشبّثه بأسباب السلامة، فضلاً عن أن يسعى للانتصار العسكري، وإنّه (عليه السّلام) مصمّم على الإصحار بعدم شرعية السلطة ومباينته لها، وبعسفها وظلمها، واستعداده للتضحية في سبيل ذلك من أجل شرف الهدف.
____________________
١ - مقتل الحسين - للخوارزمي ١/٢٣٦ - ٢٣٧ الفصل الحادي عشر في خروج الحسين من مكة إلى العراق، واللفظ له، الفتوح - لابن أعثم ٥/٩٣ ذكر كتاب الحسين (رضي الله عنه) إلى أهل الكوفة، بحار الأنوار ٤٤/٣٨٣.
٢ - مقتل الحسين - للخوارزمي ١/٢٣٦ - ٢٣٧ الفصل الحادي عشر في خروج الحسين من مكة إلى العراق، واللفظ له، تحف العقول/٢٤٥، بحار الأنوار ٤٤/٣٨٣.
٣ - اللهوف في قتلى الطفوف/٤٨ خروج الحسين من مكة إلى العراق، واللفظ له، مجمع الزوائد ٩/١٩٢ كتاب المناقب، باب مناقب الحسين بن علي (عليهم السّلام)، المعجم الكبير ٣/١١٤ - ١١٥ مسند الحسين بن علي، ذكر مولده وصفته، تاريخ دمشق ١٤/٢١٧ - ٢١٨ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، سير أعلام النبلاء ٣/٣١٠ في ترجمة الحسين الشهيد، تاريخ الإسلام ٥/١٢ مقتل الحسين، تاريخ الطبري ٤/٣٠٤ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، وغيرها من المصادر، وقد اختلفت المصادر في الوقت الذي خطب (عليه السّلام) به هذه الخطبة.
الظروف التي أحاطت بالنهضة لا تناسب انتصاره عسكري
الثاني: إنّ الظروف التي أحاطت بنهضته المباركة، وخروجه من مكة إلى العراق، كانت لا تُناسب انتصاره عسكري، ولا أقل من أنّها كانت تقتضي مزيداً من الاحتياط والتأنّي، ولو من أجل العائلة المخدّرة، كما يشهد بذلك إجماع آراء مَنْ نصحه؛ فإنّهم ذكروا لتوجيه آرائهم أموراً لا تخفى على كثير من الناس، فضلاً عنه (صلوات الله عليه).
فإقدامه على تلك النهضة، وما استتبعته من تضحيات جسام ومآسٍ قاسية، لا بدّ أن يكون لهدف آخر غير الانتصار العسكري.
ويبدو مدى وضوح الخطر عليه في خروجه للعراق، وقوّة تصميمه (عليه السّلام) عليه مع ذلك، من محاورة ابن عباس معه وهو الذي سبق منه أنّه قال: ما كنّا نشكّ وأهل البيت متوافرون أنّ الحسين بن علي يُقتل بالطفّ(١) .
حيث قال ابن عباس للإمام الحسين (عليه السّلام): إنّك قد أرجفت الناس أنّك سائر إلى العراق، فبيّن لي ما أنت صانع.
فقال (صلوات الله عليه): «قد أجمعت المسير في أحد يومي هذين إن شاء الله تعالى».
فحذّره ابن عباس، وأبدى وجه تخوّفه عليه من مسيره في حديث طويل، فقال الإمام الحسين (عليه السّلام) له: «وإنّي أستخير الله، وأنظر ما يكون».
فلمّا كان من العشي أو من الغد أتاه ابن عباس فقال: يابن عم، إنّي أتصبّر ولا أصبر، إنّي أتخوّف عليك في هذا الوجه الهلاك والاستئصال؛ إنّ أهل العراق قوم غدر فلا تقربنّهم. أقم بهذا البلد؛ فإنّك سيّد أهل الحجاز، فإن كان أهل العراق يريدونك - كما زعموا - فاكتب إليهم فلينفوا عدوّهم، ثمّ أقدم عليهم.
____________________
١ - تقدّمت مصادره في/١٧.
فإن أبيت إلّا أن تخرج فسر إلى اليمن؛ فإنّ بها حصوناً وشعاباً، وهي أرض عريضة طويلة، ولأبيك بها شيعة، وأنت عن الناس في عزلة، فتكتب إلى الناس، وترسل وتبّث دعاتك، فإنّي أرجو أن يأتيك عند ذلك الذي تحبّ في عافية.
فقال له الإمام الحسين (صلوات الله عليه): «يابن عم، إنّي لأعلم أنّك ناصح مشفق، ولكنّي قد أزمعت وأجمعت على المسير».
فقال له ابن عباس: فإن كنت سائراً فلا تسر بنسائك وصبيتك؛ فوالله إنّي لخائف أن تُقتل كما قُتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه.
ثمّ قال: لقد أقررت عين ابن الزبير بتخليتك إيّاه والحجاز والخروج منه، وهو يوم [اليوم. ظ] لا ينظر إليه أحد معك. والله الذي لا إله إلّا هو، لو أعلم أنّك إذا أخذت بشعرك وناصيتك حتى يجتمع عليّ وعليك الناس أطعتني لفعلت ذلك(١) .
وإنّما كان (صلوات الله عليه) يبرّر خروجه بدعوة أهل الكوفة له، وكثرة كتبهم إليه - بنحو قد يوحي بأنّ هدفه الانتصار العسكري -؛ لأنّ عامّة الناس، وكثير من خاصّتهم لا يستوعبون أنّ هدفه (عليه السّلام) من الخروج هو الإصحار والإعلان عن عدم شرعية السلطة في موقف يحرجها ويستثيرها، وإن ترتب على ذلك التضحية بنفسه الشريفة وبمَنْ معه، وانتهاك حرمتهم وحرمة عائلته الكريمة؛ ليتجلّى مدى ظُلامة دين الإسلام العظيم بظُلامة رعاته ورموزه
____________________
١ - تاريخ الطبري ٤/٢٨٧ - ٢٨٨ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مسير الحسين (عليه السّلام) من مكة متوجّهاً إلى الكوفة وما كان من أمره في مسيره، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/٣٨ - ٣٩ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر مسير الحسين إلى الكوفة، البداية والنهاية ٨/١٧٣ أحداث سنة ستين من الهجرة، صفة مخرج الحسين إلى العراق، الأخبار الطوال/٢٤٤ خروج الحسين بن علي بن أبي طالب إلى الكوفة، الفتوح - لابن أعثم ٥/٧٢ - ٧٣ ابتداء أخبار الحسين بن علي (عليهم السّلام)، وغيرها من المصادر.
المقدّسة، وباستيلاء أولئك المجرمين على السلطة فيه، وحكمهم باسمه.
ظهور الإحراج عليه (عليه السّلام) مع ناصحيه
ولذا كان (عليه السّلام) يبدو عليه الإحراج مع كثير من ناصحيه من أهل الرأي والمعرفة الذين يعتمدون المنطق في موازنة القوى.
وأقوى ما كان يعتذر به ممّا يصلح لأن يقنع الناس أنّه (عليه السّلام) خرج من مكة خشية أن تُهتك به حرمتها وحرمة الحرم(١) .
وفي حديث له (عليه السّلام) مع جماعة فيهم عبد الله بن الزبير: «والله، لئن أُقتل خارجاً منها بشبر أحبّ إليّ من أن أُقتل فيها، ولئن أُقتل خارجاً منها بشبرين أحبّ إليّ من أن أُقتل خارجاً منها بشبر. وأيم الله، لو كنت في حجر هامة من هذه الهوام لاستخرجوني حتى يقضوا بي حاجتهم. والله، ليعتدنَ عليّ كما اعتدت اليهود في السبت»(٢) .
وفيما عدا ذلك كان (صلوات الله عليه) تارة: يكتفي ببيان تصميمه على الخروج ويتجاهل حسابات الناصحين، أو يعدهم النظر في الأمر، أو أنّه سوف يستخير الله تعالى في ذلك، أو يشكر لهم نصحهم؛ تطييباً لخواطرهم، من دون أن يتعرّض لمناقشة حساباتهم، ثمّ لا يتراجع عن تصميمه، نظير ما تقدّم منه مع
____________________
١ - المعجم الكبير ٣/١١٩ - ١٢٠ مسند الحسين بن علي، ذكر مولده وصفته ح ٢٨٥٩، مجمع الزوائد ٩/١٩٢ كتاب المناقب، باب مناقب الحسين بن علي (عليهم السّلام)، تاريخ دمشق ١٤/٢٠٠ - ٢٠٣، ٢١١ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، سير أعلام النبلاء ٣/٢٩٢ في ترجمة الحسين الشهيد، تاريخ الإسلام ٥/١٠٦ في ترجمة الحسين بن علي (رضي الله عنه)، البداية والنهاية ٨/١٧٤ أحداث سنة ستين من الهجرة، صفة مخرج الحسين إلى العراق، وغيرها من المصادر الكثيرة.
٢ - الكامل في التاريخ ٤/٣٨ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر مسير الحسين إلى الكوفة، واللفظ له، تاريخ الطبري ٤/٢٨٩ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مسير الحسين (عليه السّلام) من مكة متوجّهاً إلى الكوفة وما كان من أمره في مسيره.
ابن عباس وغير ذلك ممّا كان منه (عليه السّلام) معه ومع غيره(١) .
وأُخرى: يعترف بصواب رأيهم، إلّا إنّه لا بدّ من تجاوزه، فقد قال لأحد بني عكرمة: «يا عبد الله، إنّه ليس يخفى عليّ، الرأي ما رأيت، ولكنّ الله لا يُغلب على أمره»(٢) .
اعتذاره (عليه السّلام) برؤياه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنّه ماضٍ لما أمره
وثالثة: يقطع الطريق عليهم، معتذراً بأنّه (عليه السّلام) رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فأمره بأمر هو ماضٍ له.
قال ابن الأثير: فنهاه جماعة، منهم: أخوه محمد بن الحنفية وابن عمر وابن عباس وغيرهم، فقال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وأمرني بأمر فأنا فاعل ما أمر»(٣) .
ولمّا سُئل عن الرؤيا قال: «ما حدّثت بها أحد، وما أنا محدّث بها أحداً حتى ألقى ربّي»، كما روي ذلك في حديثه مع عبد الله بن جعفر ويحيى بن سعيد بن العاص حينما أدركاه في الطريق بعد خروجه من مكّة المكرّمة(٤) .
____________________
١ - تاريخ دمشق ١٤/٢٠١ - ٢٠٥ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، تاريخ الطبري ٤/٢٨٧ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مسير الحسين (عليه السّلام) من مكّة متوجّهاً إلى الكوفة وما كان من أمره في مسيره، البداية والنهاية ٨/١٧٦ أحداث سنة ستين من الهجرة، صفة مخرج الحسين إلى العراق، ترجمة الحسين (عليه السّلام) من طبقات ابن سعد/٥٧ - ٥٩ ح ٢٨٣، مقتل الحسين - للخوارزمي ١/٢١٦ - ٢١٧ الفصل العاشر، الأخبار الطوال/٢٤٣ خروج الحسين بن علي بن أبي طالب إلى الكوفة، ينابيع المودّة ٣/٦٠، وغيرها من المصادر الكثيرة.
٢ - تاريخ الطبري ٤/٣٠١ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مسير الحسين (عليه السّلام) من مكّة متوجّهاً إلى الكوفة وما كان من أمره في مسيره، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/٤٣ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر مسير الحسين إلى الكوفة، الإرشاد ٢/٧٦، وغيرها من المصادر.
٣ - أُسد الغابة ٢/٢١ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، مضافاً إلى المصادر الآتية.
٤ - الكامل في التاريخ ٤/٤١ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر مسير الحسين إلى الكوفة، واللفظ له، تاريخ الطبري ٤/٢٩٢ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مسير الحسين (عليه السّلام) من =
إخباره (عليه السّلام) لأخيه بما أمره به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرؤيا
نعم، روى ابن طاووس أنّه (عليه السّلام) حدّث أخاه محمد بن الحنفية عند السحر، وهو يريد الخروج إلى العراق بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم له.
قال (قدّس سرّه): ورويت من أصل لأحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الثقة - وعلى الأصل أنّه كان لمحمد بن داود القمّي - بالإسناد عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال: «سار محمد بن الحنفية إلى الحسين في الليلة التي أراد الخروج في صبيحتها عن مكّة، فقال له: يا أخي، إنّ أهل الكوفة مَنْ قد عرفت غدرهم بأبيك وأخيك، وقد خفت أن يكون حالك كحال مَنْ مضى، فإن رأيت أن تُقيم؛ فإنّك أعزّ من في الحرم وأمنعه.
فقال: يا أخي، قد خفت أن يغتالني يزيد بن معاوية في الحرم، فأكون الذي يُستباح به حرمة هذا البيت.
فقال له ابن الحنفية: فإن خفت ذلك فصر إلى اليمن، أو بعض نواحي البر؛ فإنّك أمنع الناس به، ولا يقدر عليك أحد. فقال: أنظر فيما قلت.
فلمّا كان السحر ارتحل الحسينُ (عليه السّلام) فبلغ ذلك ابن الحنفية، فأتاه فأخذ زمام ناقته التي ركبها، فقال له: يا أخي، ألم تعدني النظر فيما سألتك؟ قال: بلى. قال: فما حداك على الخروج عاجلاً؟
فقال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما فارقتك، فقال: يا حسين، أخرج؛ فإنّ الله قد شاء أن يراك قتيلاً. فقال ابن الحنفية: إنّا لله وإنّا إليه راجعون.
فما معنى حملك هؤلاء النسوة معك وأنت تخرج على مثل هذا الحال؟
____________________
= مكّة متوجّهاً إلى الكوفة وما كان من أمره في مسيره، تاريخ دمشق ١٤/٢٠٩ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، وتهذيب الكمال ٦/٤١٨ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، وتاريخ الإسلام ٥/٩ حوادث سنة واحد وستين، مقتل الحسين، وغيرها من المصادر.
فقال له: قد قال لي: إنّ الله قد شاء أن يراهنَّ سبايا. وسلّم عليه ومضى»(١) .
بعض شواهد إصراره (عليه السّلام) على الخروج للعراق مع علمه بمصيره
وعن ابن عباس قال: لقيت الحسين وهو يخرج إلى العراق، فقلت له: يابن رسول الله لا تخرج.
فقال لي: «يابن عباس، أما علمت أنّ منيتي من هناك، وأنّ مصارع أصحابي هناك؟».
فقلت له: فأنّى لك ذلك؟
قال: «بسرٍّ سُرَّ لي، وعلمٍ أُعطيته»(٢) .
وقال ابن عساكر: وكتبت إليه عمرة بنت عبد الرحمن تُعظّم عليه ما يريد أن يصنع، وتأمره بالطاعة ولزوم الجماعة، وتخبره أنّه إنّما يُساق إلى مصرعه، وتقول: أشهد لحدّثتني عائشة أنّها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «يُقتل حسين بأرض بابل».
فلمّا قرأ كتابها قال: «فلا بدّ لي إذاً من مصرعي». ومضى(٣) .
وقريب من ذلك جوابه لأُمّ سلمة (رضي الله عنهم) لما أخبرته بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتله (عليه السّلام)(٤) .
ومرجع ذلك إلى قطع الطريق عليهم، وإلزامهما بما يعلمان به من الوعد الإلهي، مع التصميم على المضي فيه.
____________________
١ - اللهوف في قتلى الطفوف/٣٩ - ٤٠ خروج الحسين من مكة إلى العراق.
٢ - دلائل الإمامة/١٨١ - ١٨٢ في ترجمة الحسين (عليه السّلام)، ذكر معجزاته (عليه السّلام)، إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات ٤/٥٤ الباب الخامس عشر، معجزات أبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السّلام) الفصل السابع عشر.
٣ - تاريخ دمشق ١٤/٢٠٩ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، واللفظ له، تهذيب الكمال ٦/٤١٨ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، سير أعلام النبلاء ٣/٢٩٦ - ٢٩٧ في ترجمة الحسين الشهيد، تاريخ الإسلام ٥/٩ حوادث سنة واحد وستين، مقتل الحسين، ترجمة الحسين (عليه السّلام) من طبقات ابن سعد/٥٨ ح ٢٨٣، وغيرها من المصادر.
٤ - إثبات الوصية/١٧٥ قصة كربلاء، الهداية الكبرى/٢٠٣، الثاقب في المناقب/٣٣٠، مدينة المعاجز ٣/٤٨٩ - ٤٩٠، وغيرها من المصادر.
رواية الفريقين للمضامين السابقة شاهد بصحته
ولو اختصّ الشيعة برواية ذلك لأمكن للمدّعي أن يتجاهل كثرة النصوص المذكورة ومؤيّداته، ويتّهمهم باختلاق تلك النصوص من أجل
الدفاع عن شرعية هذه النهضة، وتأكيد شرف أهدافه.
لكنّ الجمهور قد شاركوهم في رواية كثير من ذلك، مع إنّه لا يتناسب مع نظرتهم للحدث، وعرضهم له بما يوحي بأنّ التخطيط للنهضة بشري؛ فإنّ رواية الجمهور لتلك النصوص مع مخالفتها لوجهة نظرهم في عرض الواقعة يشهد بشيوعه، بحيث فرضت نفسها عليهم، ولم يستطيعوا تجاهله.
رواية الفريقين إخبار الأنبياء السابقين بالفاجعة
بل، قد روى الشيعة(١) وكثير من الجمهور(٢) ما يوحي بأنّ هذا الحدث
____________________
١ - منها ما روي عن آدم (عليه السّلام) (بحار الأنوار ٤٤/٢٤٢ - ٢٤٣، ٢٤٥)، وإبراهيم (عليه السّلام) (كامل الزيارات/١٤٢ - ١٤٣، خصال الصدوق/٥٨ - ٥٩ ح٧٩، وإسماعيل (عليه السّلام) (بحار الأنوار ٤٤/٢٤٣ - ٢٤٤)، ونوح (عليه السّلام) (الأمان من أخطار الأسفار/١١٨ - ١١٩ الفصل الرابع)، وزكريا (عليه السّلام) (كمال الدين وتمام النعمة/٤٦١ الباب الثالث والأربعون، دلائل الإمامة/٥١٣، مناقب آل أبي طالب - لابن شهرآشوب ٣/٢٣٧،- وغيرها من المصادر)، وموسى (عليه السّلام) (بحار الأنوار ٤٤/٢٤٤)، وسليمان (عليه السّلام) (بحار الأنوار ٤٤/٢٤٤)، وعيسى (عليه السّلام) (الأمالي - للصدوق/٦٩٥، بحار الأنوار ٤٤/٢٤٤)، وغيرهم من الأنبياء (كامل الزيارات/١٣٧ - ١٣٩).
٢ - راجع المعجم الكبير ٣/١١١ مسند الحسين بن علي، ذكر مولده وصفته ح ٢٨٢٧، وتاريخ دمشق ١٤/١٩٩ - ٢٠٠ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، وسير أعلام النبلاء ٣/٢٩١ في ترجمة الحسين الشهيد، وتاريخ الطبري ٤/٢٩٦ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مسير الحسين (عليه السّلام) من مكّة متوجّهاً إلى الكوفة وما كان من أمره في مسيره، والفتوح - لابن أعثم ٤/٣٣٠ - ٣٣١ ابتداء أخبار مقتل مسلم بن عقيل...، ومقتل الحسين - للخوارزمي ١/١٦٥ الفصل الثامن، وحياة الحيوان ١/١١٠ عند كلامه عن الأوز، وغيرها من المصادر الكثيرة. =
العظيم قد تحدّث عنه الأنبياء السابقون (على نبينا وآله وعليهم أفضل الصلاة والسّلام) في غابر العصور، وعُرف قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزمان طويل.
وهو المناسب لما ورد من أنّ أُمّ المؤمنين أُمّ سلمة (رضي الله عنها)(١) وغير واحد
____________________
= ومما يشهد بذلك ما رواه ابن عساكر بأسانيد متعدّدة إلى يحيى بن يمان قال: «أخبرني إمام مسجد بني سليم قال: غزا أشياخ لنا الروم، فوجدوا في كنيسة من كنائسهم:
كيف ترجو أمة قتلت حسيناً |
شفاعة جدّه يوم الحساب |
فقالوا: منذ كم وجدتم هذا الكتاب في هذه الكنيسة؟ قالوا: قبل أن يخرج نبيّكم بستمائة». تاريخ دمشق ١٤/٢٤٢ - ٢٤٤ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، ونقله عنه في البداية والنهاية ٨/٢١٨ في أحداث سنة إحدى وستين، فصل بلا عنوان بعد ذكر صفة مقتله، ورواه بسند آخر الطبراني في المعجم الكبير ٣/١٢٤ في مسند الحسين بن علي في ذكر مولده وصفته ح ٢٨٧٤، ونقله عنه في مجمع الزوائد ٩/١٩٩ كتاب المناقب، باب مناقب الحسين بن علي (عليهم السّلام)، ورواه أيضاً المزي بسند آخر في تهذيب الكمال ٦/٤٤٢ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب.
وكذا ما رواه ابن عساكر أيضاً بسندين عن الأصمعي قال: مررت بالشام على باب دير، وإذا على حجر منقور كتابة بالعبرانية، فقرأته، فأخرج راهب رأسه من الدير، وقال لي: يا حنيفي أتحسن تقرأ العبرانية؟ قلت: نعم. قال لي: اقرأ. فقلت:
أيرجو معشر قتلوا حسيناً |
شفاعة جدّه يوم الحساب |
فقال لي الراهب: يا حنيفي، هذا مكتوب على هذا الحجر قبل أن بُعث صاحبك يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاثين عاماً، تاريخ دمشق ٣٧/٥٧ - ٥٨ في ترجمة عبد الملك بن قريب بن عبد الملك.
وكذا ما رواه السمهودي عن محمد بن سيرين أنّه قال: وجد حجر قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثلاثمئة سنة عليه مكتوب بالسريانية، فنقلوه إلى العربية، فإذا هو:
أترجوا أمة قتلت حسيناً |
شفاعة جدّه يوم القيامه |
جواهر العقدين ق٢ ج٢/٣٨٧ الذكر الرابع عشر، وروى مثله في ينابيع المودّة ٣/٤٦، ونظم درر السمطين/٢١٩، وغيرها من المصادر.
١ - تاريخ دمشق ١٤/٢٤٠ في ترجمة الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب، البداية والنهاية ٨/٢١٩ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة فصل من دون ترجمة، نظم درر السمطين/٢١٧. =
في أماكن مختلفة(١) سمعوا بعد قتل الإمام الحسين (صلوات الله عليه) هاتفاً يهتف ويقول:
أيّها القاتلون جهلاً حسين |
أبشروا بالعذابِ والتنكيلِ |
|
كلّ أهلِ السماءِ يدعو عليكم |
من نبي وملَكٍ وقبيلِ |
|
قد لُعنتم على لسانِ ابن داود |
وموسى وصاحبِ الإنجيلِ |
حيث يكشف ذلك عن أهميته عند الله تعالى في الدعوة إليه حتى أطلع عليه أنبياءه، كما أطلعهم على رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخاتمة للرسالات، والتي تتضمّن دين الإسلام الخاتم للأديان والذي يكون هذا الحدث من الأحداث المهمّة المتعلّقة به.
وذلك يرجع إلى أنّ سيّد الشهداء الإمام الحسين (صلوات الله عليه) قد أُعِد لمهمّة إلهية تتناسب مع هذا الإعلام الإلهي المكثّف، ومع حجم التضحية التي يقدم عليها.
وهو المناسب لأهمية دين الإسلام العظيم في الدعوة إلى الله تعالى؛ لكونه خاتم الأديان وأكمله، وبه بقاء الدعوة لله (عزّ وجلّ)، وخلودها في الأرض، حيث تكتسب الأحداث المؤثّرة فيه أهمية تتناسب مع أهميته.
ولاسيما إنّ هذا الحدث لم يكن نصراً لدين الإسلام فحسب، بل هو انتصار للأديان السماوية بأجمعها على ما يأتي التنبيه له في الفصل الأوّل من الخاتمة إن شاء الله تعالى.
____________________
= مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٩٥ الفصل الثاني عشر، وقد اقتصر على البيت الأوّل والثالث.
١ - تاريخ الطبري ٤/٣٥٨ أحداث سنة إحدى وستين، الفتوح - لابن أعثم ٥/١٥٦ بعد ذكر كتاب عبيد الله بن زياد إلى يزيد بن معاوية وبعثه إليه برأس الحسين بن علي (رضي الله عنهم)، كتاب الهواتف/٨٧ باب هواتف الجن، الكامل في التاريخ ٤/٩٠ أحداث سنة إحدى وستين ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، وقد اختلفت المصادر في بعض ألفاظ الأبيات وقد أثبتناها بلفظ الكامل في التاريخ.
كتابه (عليه السّلام) إلى بني هاشم بالفتح الذي يحقّقه
ولعلّه إلى هذا يشير كتابه (صلوات الله عليه) الذي كتبه من مكّة المكرّمة - وهو يعدّ العدّة لنهضته - إلى بني هاشم في المدينة المنوّرة: «بسم الله الرحمن الرحيم. من الحسين بن علي إلى محمد بن علي ومَنْ قِبَله من بني هاشم. أمّا بعد، فإنّ مَنْ لحق بي استشهد، ومَنْ لم يلحق بي لم يدرك الفتح. والسّلام»(١) .
حيث لا يبعد أن يكون مراده (عليه السّلام) في كتابه هذا أنّ في نهضته التي تنتهي به وبمَنْ معه للقتل والشهادة فتحاً للدين، وللدعوة إلى الله تعالى يتناسب مع حجم التضحية التي تحصل فيها.
إخبار الإمام السجّاد (عليه السّلام) بأنّ أباه (عليه السّلام) هو الغالب
وهو المناسب لما عن الإمام زين العابدين (صلوات الله عليه) في جوابه لإبراهيم بن طلحة حينما سأله بعد رجوعه بالعائلة الثاكلة للمدينة كأنّه شامت: يا علي بن الحسين مَنْ غلب؟
حيث قال له (عليه السّلام): «إذا أردت أن تعلم مَنْ غلب ودخل وقت الصلاة فأذن ثمّ أقم»(٢) .
فإنّه كالصريح في أنّ تلك الفاجعة الفظيعة هي السبب في الحفاظ على الصلاة التي هي عمود الدين، وأظهر شعائره، كما يكشف عن شدّة الخطر الذي يتعرّض له الدين لو لم يقف في وجهه الإمام الحسين (صلوات الله عليه) بنهضته المباركة التي خُتمت بهذه الفاجعة.
____________________
١ - كامل الزيارات/١٥٧، واللفظ له، دلائل الإمامة/١٨٨، الخرائج والجرائح ٢/٧٧١ - ٧٧٢، بصائر الدرجات/٥٠٢، وغيرها من المصادر.
٢ - الأمالي - للطوسي/٦٧٧.
خلود الفاجعة يناسب أهميتها
وذلك يتناسب مع خلود هذه الملحمة الشريفة والفاجعة العظمى، وما قدّره الله (عزّ وجلّ) لها من أسباب الظهور والانتشار، رغم المعوّقات الكثيرة، والجهود المكثّفة من قبل الظالمين، والجاهلين أو المتجاهلين لثمراتها وبركاتها، من أجل خنقها والقضاء عليها، أو تحجيمها والتخفيف من غلوائها، ومن تفاعل الناس بها وانشدادهم نحوها.
فإنّ ذلك بمجموعه يؤيّد عظمة هذه الملحمة الإلهية، وأهمية الثمرات المترتبة عليها لصالح الدعوة إلى الله تعالى، وحفظ دينه العظيم الذي هو خاتم الأديان، والذي لا بدّ أن يكون واجداً لمقوّمات البقاء والخلود، والظهور والانتشار، لتسمع دعوته، وتتم حجّته على الناس( لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ ) (١) .
كما إنّه نتيجة لما سبق يحسن التنبيه لأمرين:
لا موجب لإطالة الكلام في تفاصيل النهضة الشريفة
أحدهما: إنّه لا ينبغي إطالة الكلام في تقييم بعض خصوصيات النهضة الشريفة، مثل توقيتها، حيث خرج (صلوات الله عليه) من مكّة المكرّمة قبل الحجّ، ومثل حمل العائلة الكريمة، واختيار العراق دون غيره من المناطق التي يشيع فيها الولاء لأهل البيت (صلوات الله عليهم)، وغير ذلك.
إذ بعد أن ظهر أنّ النهضة كانت بعهد من الله سبحانه وتعالى، فلا بدّ أن تكون تفاصيلها وخصوصياتها ذات الأثر فيها بعهد منه (عزّ وجلّ)، لمصالح
____________________
١ - سورة الأنفال/٤٢.
هو أعلم بها، وربما بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووصلت للإمام الحسين (عليه السّلام) من طريقه، ولاسيما بعد البناء على عصمة الإمام (صلوات الله عليه).
وقد كتب غير واحد في توجيه كثير من خصوصياتها ما لا يسعنا إطالة الكلام فيه بعد ما ذكرنا، على أنّه قد يظهر من حديثنا هذا - تبعاً - بعض الفوائد المترتّبة على بعض تلك الأمور.
عظمة الإمام الحسين (عليه السّلام) وروح التضحية التي يحمله
ثانيهما: إنّه ممّا تقدّم تتجلّى عظمة الإمام الحسين (صلوات الله عليه) وروح التضحية في سبيل الله تعالى التي يتحلّى بها، وقوّة العزيمة والتصميم اللذين يحملهما بين جنبيه.
فإنّ الغالب أنّ الذين يضحّون إمّا أن يتشبثوا بأمل السلامة ونجاح المشروع الذي يخطّطون له، فيشرعون في تنفيذه ويدخلون في المعركة حتى إذا أخطأوا وفشل مشروعهم عسكرياً منعهم دينهم، أو أبت لهم كرامتهم وحميّتهم التراجع والاستسلام من أجل السلامة؛ فيثبتون حتى النهاية.
وإمّا أن يُفاجَأوا بالمعركة من دون تخطيط سابق لها، وتنسد أمامهم طرق النجاح؛ فيمنعهم دينهم أو حميتهم أيضاً من الاستسلام طلباً للسلامة ويثبتوا حتى النهاية.
أمّا أن يدخل الإنسان في مشروع طويل الأمد يعلم مسبقاً بأنّه ينتهي بمثل هذه التضحيات الجسام والفجائع الفادحة، ويخطّط لتنفيذه بصلابة وعزم، فهو أمر يحتاج إلى قابلية استثنائية.
والناظر في تفاصيل واقعة الطفّ - بموضوعية وإنصاف - يرى أنّ الإمام
الحسين (صلوات الله عليه) منذ امتنع من بيعة يزيد في أواخر شهر رجب، وتحرّك ركبه من المدينة المنوّرة إلى مكّة المكرّمة، صمّم على المضي في مشروعه وتحقيق هدفه عالماً أنّ ذلك ينتهي بقتله وقتل أهل بيته نجوم الأرض من آل عبد المطلب - كما تقول العقيلة زينب (عليها السّلام) في خطبتها الجليلة(١) - مع الصفوة من أصحابه، مع ما يترتّب على ذلك من نهب رحله، وانتهاك حرمته، وسبي عياله، والتشهير به وبهم، وتركهم غنيمة بأيدي تلك الوحوش الكاسرة، والنفوس المغرقة في الجريمة والرذيلة.
ولم يمنعه شيء من ذلك عن التصميم والتخطيط والإصرار والاستمرار حتى النهاية التي حصلت بعد ما يقرب من ستة أشهر.
تحلّي الإمام الحسين (عليه السّلام) بالعاطفة
ولاسيما أنّه (صلوات الله عليه) لم تجفّ عاطفته في هذه المدّة الطويلة، ولم يتجرّد عنها ويدعها جانباً، كما قد يحصل لكثير من ذوي التصميم والإصرار على الدخول في الصراعات المضنية ومقارعة الأهوال، بل كان (عليه السّلام) - كسائر أهل بيته - متكامل الإنسانية. فهو أشدّ الناس عاطفة، وأرقّهم قلباً، يتفاعل مع الآلام والمصائب التي ترد عليه، وتستثيره المناسبات الشجيّة حسرة وعبرة، كما يظهر بمراجعة تفاصيل الواقعة تاريخياً، وتقدم منّا التعرّض لبعض مفردات ذلك، وربما يأتي شيء منه في أثناء حديثنا هذا.
وذلك يزيد في معاناته (عليه السّلام) في هذه المدّة الطويلة، خصوصاً في تخطّي مفاصلها المثيرة للعاطفة، والباعثة على الحسرة، كما انتبهت لذلك أُخته العقيلة زينب الكبرى (عليها السّلام) حينما أنشد (صلوات الله عليه) ليلة العاشر من المحرّم:
____________________
١ - راجع ملحق رقم (٤).
يا دهرُ أفٍّ لكَ من خليل |
كم لكَ بالإشراقِ والأصيلِ |
|
من صاحبٍ أو طالبٍ قتيل |
والدهرُ لا يقنعُ بالبديلِ |
|
وإنّما الأمرُ إلى الجليل |
وكلّ حيّ سالكٌ سبيلي |
حيث لم تملك نفسها أن وثبت تجرّ ثوبها وإنّها لحاسرة حتى انتهت إليه، فقالت: «واثكلاه. ليت الموت أعدمني الحياة. اليوم ماتت أُمّي فاطمة وعلي أبي وحسن أخي. يا خليفة الماضين وثمال الباقي». فنظر (عليه السّلام) إليها، وقال: «يا أُخيه، لا يذهبنَّ حلمك الشيطان». قالت: بأبي أنت وأُمّي يا أبا عبد الله! استقتلت نفسي فداك! فردّ (عليه السّلام) غصّته وترقرقت عيناه، وقال: «لو تُرك القطا ليلاً لنام». فقالت (عليها السّلام): يا ويلتي! أفتُغصب نفسك اغتصاباً؟! فذلك أقرح لقلبي، وأشدّ على نفسي(١) .
ولكن عاطفته (صلوات الله عليه) مهما بلغت لم تمنعه من المضي في طريقه، ومن تصميمه على الوصول للنهاية المفجعة؛ كلّ ذلك لفنائه (عليه السّلام) في ذات الله تعالى، ولأنّ هدفه الأسمى رضاه (جلّ شأنه)، كما أفصح عن ذلك في أحاديثه المتفرّقة، خصوصاً خطبته الجليلة حينما أراد الخروج من مكّة، التي سبق التعرّض
____________________
١ - تاريخ الطبري ٤/٣١٩ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/٥٩ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، أنساب الأشراف ٣/٣٩٣ خروج الحسين بن علي من مكة إلى الكوفة، مقاتل الطالبيين/٧٥ مقتل الحسين بن علي (عليهم السّلام)، نهاية الأرب في فنون الأدب ٢٠/٢٧٢ - ٢٧٤ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مسير الحسين بن علي (رضي الله عنهم) وخبر مَنْ نهاه عن المسير، إعلام الورى بأعلام الهدى/٤٥٧، اللهوف في قتلى الطفوف/٥٠ وصول الحسين إلى كربلاء، وقريب منه في البداية والنهاية ٨/١٩٢ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، صفة مقتله مأخوذة من كلام أئمّة الشأن، وتاريخ اليعقوبي ٢/٢٤٤ مقتل الحسين بن علي، والمنتظم ٥/٣٣٨ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام)، وغيرها من المصادر.
لها آنفاً(١) .
ومن أقواله المرويّة عنه (عليه السّلام): «هوّن عليّ ما نزل بي أنّه بعين الله»(٢) ، و: «عند الله أحتسب نفسي وحُماة أصحابي»(٣) ... إلى غير ذلك.
الموقف المشرّف لِمَنْ في ركبه من عائلته وصحبه
والملفت للنظر - مع كلّ ذلك - أنّه (صلوات الله عليه) استطاع أنّ يختار لنهضته الشريفة من أهل بيته وأنصاره مَنْ لا يتراجع عنها بعد أن اقتنع بها، وكان بوسعهم التراجع في أيّ وقت أرادوا.
لكنّهم آمنوا بقيادته، واستسلموا لما يقرّره حتى النفس الأخير، مع قوّة في البصيرة، ومزيد من السرور والشعور بالفوز والسعادة، وقد آمنوا بمشروعه كما آمن هو (عليه السّلام).
بل قد ثبتوا معه (عليه السّلام) ولم يتركوه حتى بعد أن أذن لهم بالانصراف وجعلهم في حلّ من بيعته، وكان كلامهم في التعقيب على ذلك يؤكّد على الإصرار على مواساته بأنفسهم والقتال دونه والتضحية في سبيله، وعلى الشعور بالفوز والسعادة بذلك. ولا يسعنا استقصاؤه لكثرته.
كما إنّه يأتي في حديثنا هذا منهم بعض النكات الملفتة للنظر، والتي تحمل على المزيد من الإعجاب والاحترام لهم رفع الله تعالى شأنهم.
____________________
١ - تقدّمت مصادرها في/٥٠.
٢ - اللهوف في قتلى الطفوف/٦٩ شهادة أهل بيته (عليهم السّلام).
٣ - مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/١٩، بحار الأنوار ٤٥/٢٧، ووردت هكذا: «أحتسب نفسي وحماة أصحابي» في تاريخ الطبري ٤/٣٣٦ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، والكامل في التاريخ ٤/٧١ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، ونهاية الأرب في فنون الأدب ٢٠/٢٨٣ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ما تكلّم به الحسين.
نعم، ورد أنّ الضحّاك بن عبد الله المشرفي قال للإمام الحسين (صلوات الله عليه): إنّي أُقاتل عنك ما رأيت مقاتل، فإذا لم أرَ مقاتلاً فأنا في حلّ من الانصراف، وإنّه انصرف حين لم يجد مقاتلاً(١) .
وهذا في الحقيقة ليس تراجعاً عن موقف مسبقاً، بل هو قصور في الموقف من أوّل الأمر، مع تنفيذه كاملاً.
وحتى عائلته الكريمة التي رأت من بعده الأهوال لم ينقل عن أيّ منها مَنْ يدل على استنكاره لموقفه (عليه السلام) أو الشكوى منه في استمراره إلى النهاية المفجعة، بل يظهر من مواقف كثير منها الإيمان بمشروعه (عليه السّلام)، وقوّة البصيرة بأنّ عاقبته النجاح والفلاح.
ويكفينا من ذلك قول العقيلة زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين (عليهم السّلام) في خطبتها في مجلس يزيد: فلئن اتّخذتنا مغنماً لتجدنا وشيكاً مغرماً، حين لا تجد إلّا ما قدّمت يداك، وإنّ الله ليس بظلام للعبيد. فإلى الله المشتكى وعليه المعوّل. فكد كيدك، واسعَ سعيك، وناصب جهدك. فوالله لا تمحو ذكرنا، ولا تميت وحينا، ولا تدرك أمدنا، ولا ترحض عنك عارها، ولا تغيب منك شنارها. فهل رأيك إلّا فند، وأيّامك إلّا عدد، وشملك إلّا بدد، يوم ينادي المنادي:( أَلاَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ) . فالحمد لله الذي ختم لأولنا بالسعادة والرحمة، ولآخرنا بالشهادة والمغفرة...(٢) .
وهذا أمر نادر لا يسهل حصوله لولا العناية الإلهية والتسديد الربّاني.
____________________
١ - الكامل في التاريخ ٤/٧٣ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، واللفظ له، تاريخ الطبري ٤/٣٣٩ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة.
٢ - راجع ملحق رقم (٤).
المقصد الأوّل
في أبعاد فاجعة الطفّ وعمقها
وردود الفعل المباشرة لها
والكلام في ذلك في فصلين:
الفصل الأوّل
في أبعاد فاجعة الطفّ وعمقه
تمهيد:
من المعلوم من مذهب أهل البيت (صلوات الله عليهم) أنّ الخلافة والإمامة حقّ لهم مجعول من قِبَل الله تعالى، وأنّه لا شرعية لخلافة كلّ مَنْ تقمّصها من غيرهم، وعلى ذلك ابتنت نهضة الإمام الحسين (صلوات الله عليه)، كما يأتي - عند الكلام فيما كسبه التشيّع من هذه النهضة المباركة - إن شاء الله تعالى.
استنكار جمهور المسلمين لعهد معاوية ليزيد
أمّا الجمهور فخلافتهم وإن ابتنت على عدم الانضباط بنظام محدّد، بل جروا أخيراً على شرعية الإمامة المبنيّة على النصّ بولاية العهد من السابق
للاحق بلحاظ قربه النسبي منه، بغضّ النظر عن مؤهّلاته الشخصية، إلّا أنّهم استنكروا عهد معاوية لابنه يزيد بالخلافة في وقته.
أوّلاً: لأنّه أوّل مَنْ فتح هذا الباب، وتجاهل سيرة مَنْ قبله من خلفائهم، خصوصاً الشيخين اللذين لهما مكانة خاصة في نفوسهم.
ولاسيما أنّ من جملة دوافع قريش لصرف الخلافة عن أهل البيت (صلوات الله عليهم) هو علمهم بأنّها إذا صارت لهم لم تخرج عنهم، حتى قال قائلهم: وسّعوها في قريش تتسع(١) .
فإذا فُتح الباب لولاية العهد بقيت في آل معاوية ولم تخرج عنهم لبطون قريش، وهو عين ما فرّوا منه.
وثانياً: لابتنائها على الإرغام والقسر، والاستعانة على ذلك بالترغيب والترهيب والخداع والمكر، كما يظهر بأدنى نظر في تاريخه، وإذا غضّت قريش النظر عن ذلك في حقّ الأوّلين؛ لأنّه يوافق مصلحتها في صرف الخلافة عن بني هاشم، فهي لا تقبله من معاوية بعد أن كان يضرّ بمصالحها.
كما إنّ عموم المسلمين إذا غضّوا النظر عنه في حقّ الأوّلين؛ لجهلهم بما حصل، أو لحبّهم لهم، أو حسن ظنّهم بهم - لما يأتي من دواعي ذلك في حقّهم - فهم لا يرتضونه من معاوية؛ لعدم الموجب لذلك.
وثالثاً: لعدم مناسبة واقع يزيد وسلوكه المشين للخلافة، خصوصاً مع وجود جماعة من أعيان الصحابة وأولاد المهاجرين الأوّلين لهم المقام الاجتماعي الرفيع، والمكانة العليا في النفوس، وعلى رأسهم الإمام الحسين (صلوات الله عليه).
وقد أكّد ذلك أنّ تجربة أبيه معاوية في الحكم - الذي تسلّط بالقوّة والقهر والخداع والمكر - كانت مرّة على المسلمين في الجانبين الديني والمادي، كما يظهر
____________________
١ - شرح نهج البلاغة ٦/٤٣.
بأدنى نظر في سيرته، وكان المنتظر من يزيد أن يزيدَ على أبيه في معاناة المسلمين في دينهم ودنياهم.
وإذا كان بعض متأخري الجمهور يحاول الدفاع عن بيعة يزيد، وإضفاء الشرعية عليها بعد أن شاعت هذه الأمور في الخلفاء وألفها الناس، فهو يخالف ما عليه ذووا المقام والمكانة في المسلمين في الصدر الأوّل، بل حتى عامّة الناس.
ولذا لم يثبت بوجه معتدٍّ به أنّ شخصاً منهم حاول ردع الإمام الحسين (عليه السّلام) عن الخروج ببيان شرعية خلافة يزيد، وكلّ مَنْ أشار عليه بترك الخروج فإنّما أشار عليه لخوفه عليه من فشل مشروعه، ومن غشم الأمويين الذين لا يقفون عند حدّ في تحقيق مقاصدهم والإيقاع بمَنْ يقف في طريقهم.
غاية الأمر أنّه قد يُنسب لبعض الناس أنّه أضاف إلى ذلك التذكير بمحذور شقّ كلمة الأُمّة وتفريق جماعتها، كما يأتي إن شاء الله تعالى.
ولذا لا ريب عند خاصّة المسلمين، وذوي المقام الرفيع عند الجمهور ممّن عاصر الحدث في أنّ خروج الإمام الحسين (صلوات الله عليه) لم يكن جريمة منه يستحق عليها العقاب، فضلاً عن القتل وما استتبعه من الجرائم، بل كلّ ما وقع عليه هو عدوان من الأمويين وإجرام منهم.
كان الإمام الحسين (عليه السّلام) مسالماً في دعوته للإصلاح
ويزيد في الأمر أنّ الإمام الحسين (صلوات الله عليه) حينما رفع مشروعه الإصلاحي لم يرفعه بلسان الإلزام والتهديد، ولم يلجأ فيه للّفّ والدوران، والمكر والخديعة من أجل الاستيلاء على السلطة، بل بلسان النصيحة والتذكير.
فهو (عليه السّلام) يقول في وصيته لأخيه محمد بن الحنفية: «وإنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً، ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنّما خرجت لطلب
الإصلاح في أُمّة جدّي (صلى الله عليه وآله)، أُريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر... فمَنْ قبلني بقبول الحقّ فالله أولى بالحقّ، ومَنْ ردّ عليّ هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحقّ، وهو خير الحاكمين»(١) .
كما إنّه (عليه السّلام) لم يختر الكوفة من أجل أن يخرج أهلها من طاعة يزيد لطاعته ويرغمهم على ذلك، بل لامتناعهم بأنفسهم من القبول ببيعة يزيد.
فقد تضمّنت كتبهم:... إنّه ليس علينا إمام؛ فأقبل، لعلّ الله أن يجمعنا بك على الحقّ. والنعمان بن بشير في قصر الإمارة لسنا نجتمع معه في جمعة، ولا نخرج معه إلى عيد...(٢) . و: أمّا بعد، فحي هلا، فإنّ الناس ينتظرونك، لا إمام لهم غيرك...(٣) . و: أمّا بعد، فقد اخضرّ الجناب، وأينعت الثمار، وطمّت الجِمام(٤) ، فإذا شئت فاقدم علينا؛ فإنّما تقدم على جند لك مجنّدة(٥) ، ونحو ذلك.
____________________
١ - تأتي مصادرها في أوائل المقام الثاني في الجانب العاطفي/٣٩٨.
٢ - تاريخ الطبري ٤/٢٦٢ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين (عليه السّلام) للمصير إلى ما قبلهم، وأمر مسلم بن عقيل (رضي الله عنه)، واللفظ له، أنساب الأشراف ٣/٣٦٩ أمر الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام)، الكامل في التاريخ ٤/٢٠ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين بن علي ليسير إليهم وقتل مسلم بن عقيل، الإمامة والسياسة ٢/٤ ولاية الوليد المدينة وخروج الحسين بن علي، الإرشاد - للشيخ المفيد ٢/٣٧، وغيرها من المصادر.
٣ - تاريخ اليعقوبي ٢/٢٤٢ أيام يزيد بن معاوية، واللفظ له، أنساب الأشراف ٣/٣٧٠ أمر الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام)، ومثله في الإرشاد ٢/٣٨ إلّا إنّه بدل قوله: (لا إمام لهم غيرك) (لا رأي لهم غيرك)، وكذا في تاريخ الطبري ٤/٢٦٢ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين (عليه السّلام) للمصير إلى ما قبلهم وأمر مسلم بن عقيل (رضي الله عنه)، والفصول المهمّة ٢/٧٨٧ الفصل الثالث، فصل في مخرجه (عليه السّلام) إلى العراق، والفتوح - لابن أعثم ٥/٣٣ ذكر أخبار الكوفة وما كان من كتبهم إلى الحسين بن علي (رضي الله عنهما)، وغيرها من المصادر.
٤ - طما البحر والنهر: أمتل. والجِمام جمع جَمة: البئر الكثيرة الماء. والمراد الكناية عن حصول الوقت المناسب للعمل، وتوفّر آليات النجاح وأسبابه.
٥ - أنساب الأشراف ٣/٣٧٠ أمر الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام)، واللفظ له، الإرشاد ٢/٣٨، إعلام الورى بأعلام الهدى ١/٤٣٦، تاريخ الطبري ٤/٢٦٢ أحداث سنة ستين من الهجرة: =
وقد جاء في كتابه (صلوات الله عليه) الذي كتبه لهم مع مسلم بن عقيل (عليه السّلام): «وقد فهمت كلّ الذي اقتصصتم وذكرتم، ومقالة جلّكم: إنّه ليس علينا إمام؛ فأقبل، لعلّ الله أن يجمعنا بك على الهدى والحقّ. وإنّي باعث إليكم أخي وابن عمّي، وثقتي من أهل بيتي، فإن كتب إليّ أنّه قد اجتمع رأي ملئكم وذوي الحجا والفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكم، وقرأت في كتبكم، أقدم عليكم وشيكاً إن شاء الله...»(١) .
ولمّا التقى بالحرّ وأصحابه في الطريق خطبهم، فقال: «أيّها الناس، إنّها معذرة إلى الله وإليكم؛ إنّي لم آتكم حتى أتتني كتبكم ورسلكم أن أقدم علينا؛ فليس لنا إمام، لعلّ الله أن يجعلنا بك على الهدى؛ فقد جئتكم، فإن تعطوني ما أطمئن إليه من عهودكم أقدم مصركم، وإن لم تفعلوا، أو كنتم لمقدمي كارهين، انصرفت عنكم إلى المكان الذي أقبلت منه»(٢) .
وخطبهم خطبة أُخرى بعد صلاة العصر تتضمّن ذلك أيضاً(٣) .
وحينما ورد عليه عمر بن سعد بجيشه أرسل إليه قرّة بن قيس الحنظلي؛ ليسأله عمّا جاء به وماذا يريد، فقال (عليه السّلام) له: «كتب إليّ أهل مصركم هذا أن أقدم.
____________________
= ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين (عليه السّلام) للمصير إلى ما قبلهم، وأمر مسلم بن عقيل (رضي الله عنه)، الفتوح - لابن أعثم ٥/٣٣ ذكر أخبار الكوفة وما كان من كتبهم إلى الحسين بن علي (رضي الله عنهما)، وغيرها من المصادر.
١ - الإرشاد ٢/٣٩، واللفظ له، تاريخ الطبري ٤/٢٦٢ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين (عليه السّلام) للمصير إلى ما قبلهم وأمر مسلم بن عقيل (رضي الله عنه).
٢ - الكامل في التاريخ ٤/٤٧ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، واللفظ له، تاريخ الطبري ٤/٣٠٣ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، الفتوح - لابن أعثم ٥/٨٦ ذكر الحرّ بن يزيد الرياحي لما بعثه عبيد الله بن زياد لحربه الحسين بن علي (رضي الله عنهما)، الإرشاد ٢/٧٩، وغيرها من المصادر.
٣ - الإرشاد ٢/٧٩، تاريخ الطبري ٤/٣٠٣ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، الكامل في التاريخ ٤/٤٧ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، مقتل الحسين (رضي الله عنه).
فأمّا إذ كرهتموني فأنا أنصرف عنكم»(١) .
وفي حديث عقبة بن سمعان مولى الرباب زوجة الحسين (عليه السلام) - وكان قد صحب الإمام الحسين (صلوات الله عليه) في مسيرته الطويلة من المدينة إلى حين مقتله - أنّه (عليه السّلام) قال: «دعوني أرجع إلى المكان الذي أقبلت منه، أو دعوني أذهب في هذه الأرض العريضة حتى ننظر إلى ما يصير إليه أمر الناس»(٢) .
ومن هنا لم يقع منه ما يستحق به العقاب والتنكيل، فضلاً عن تلك الجرائم الوحشية التي قام بها الأمويون والتي هزّت ضمير المسلمين.
وبعد ذلك كلّه فلنستعرض بإيجاز الجرائم المذكورة:
قتل الإمام الحسين (عليه السّلام) هو الجريمة الأولى
ولا ينبغي الإشكال في أنّ أعظم جريمة من الناحية الواقعية - بل حتى العاطفية - في هذه الفاجعة الممضة هو قتل شخص الإمام الحسين (صلوات الله عليه)، لما يتمتّع به:
أوّلاً: من مقام ديني رفيع يستحق به الولاء والتقديس، كما يتّضح بالرجوع إلى ما ورد في حقّه وحقّ أهل بيته (صلوات الله عليهم) في الكتاب المجيد، وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممّا لا يسعنا استيعابه بإيجاز، فضلاً عن تفصيل الكلام فيه، ولاسيما مع وضوحه وشيوعه، وتيسر الاطلاع عليه بالرجوع للمصادر الكثيرة
____________________
١ - الإرشاد ٢/٨٥، واللفظ له، الفتوح - لابن أعثم ٥/٩٧ - ٩٨ ذكر نزول الحسين (رضي الله عنه) بكربلاء، تاريخ الطبري ٤/٣١١ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، الكامل في التاريخ ٤/٥٣ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، وغيرها من المصادر.
٢ - الكامل في التاريخ ٤/٥٤ - ٥٥ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، واللفظ له، تاريخ الطبري ٤/٣١٣ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، البداية والنهاية ٨/١٩٠ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، صفة مقتله مأخوذة من كلام أئمّة الشأن.
للفريقين.
وإذا اختصّ الشيعة بالقول بالنصّ الإلهي على إمامة الحسين (صلوات الله عليه)، وأنّه هو الإمام الحقّ دون غيره، فلا إشكال بين المسلمين قاطبة في أنّه (عليه السّلام) في عصره هو الرجل الأوّل في المسلمين، أفضلهم عند الله (عزّ وجلّ)، وأرفعهم مقاماً، وأعظمهم كرامة، وأولاهم بالإمامة من غيره.
وقال البلاذري: وكان رجال من أهل العراق ولثمان أهل الحجاز يختلفون إلى الحسين يجلّونه ويعظّمونه، ويذكرون فضله، ويدعونه إلى أنفسهم، ويقولون: إنّا لك عضد ويد؛ ليتّخذوا الوسيلة إليه، وهم لا يشكّون في أنّ معاوية إذا مات لم يعدل الناس بحسين أحداً(١) .
وثانياً: من قربه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو بقيّة أهل البيت الذين كان صلى الله عليه وآله وسلم يخصّهم بعواطفه وألطافه، ولازال بقايا الصحابة يذكرون مفردات ذلك، ويحدّثون به، حتى إنّ غير واحد من الصحابة أنكروا على عبيد الله بن زياد ويزيد بن معاوية حينما أخذا ينكتان ثغر الإمام الحسين (صلوات الله عليه) بالقضيب لما وضع رأسه بين أيديهما، وذكروا لهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يُقبّل ثغره، كأنس بن مالك(٢) ،
____________________
١ - أنساب الأشراف ٣/٣٦٦ أمر الحسين بن علي بن أبي طالب.
٢ - مجمع الزوائد ٩/١٩٥ كتاب المناقب، باب مناقب الحسين بن علي (عليهما السّلام)، المعجم الكبير ٣/١٢٥ مسند الحسين بن علي، ذكر مولده وصفته، البداية والنهاية ٦/٢٦٠ الأخبار بمقتل الحسين بن علي (رضي الله عنهما)، و٨/٢٠٧ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، صفة مقتله مأخوذة من كلام أئمّة الشأن، بغية الطلب في تاريخ حلب ٣/٣٨ في ترجمة الحسين بن علي بن عبد مناف أبي طالب، وغيرها من المصادر.
وقد روي ما ظاهره الإنكار في صحيح البخاري ٤/٢١٦ كتاب بدء الخلق، باب مناقب المهاجرين وفضلهم، وسنن الترمذي ٥/٣٢٥ أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، باب بعد باب مناقب أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب، ومسند أحمد ٣/٢٦١ مسند أنس بن مالك (رضي الله تعالى عنه)، =
وزيد بن أرقم(١) ، وأبو برزة الأسلمي(٢) ، وربما غيرهم(٣) .
وبالجملة: كان الناس إذا رأوا الحسين (صلوات الله عليه) ذكروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتذكّروا مشاهده معه، وما كان يعامله من مظاهر الحبّ والحنان والتكريم والتبجيل؛ وذلك ممّا يوجب مزيداً من الانشداد الديني والعاطفي نحوه (عليه السّلام).
وثالثاً: من مؤهّلات شخصيته؛ من عقل ودين، واستقامة وشجاعة، وعلم وعمل، وخلق وسلوك، وسخاء وحسن معاشرة، ومخالطة مع الناس... إلى غير ذلك؛ ممّا يفرض حبّ الخاصّة والعامّة له (عليه السّلام)، واحترامهم إيّاه، وانشدادهم نحوه.
____________________
= وصحيح ابن حبان ١٥/٤٢٩ كتاب إخباره صلى الله عليه وآله وسلم عن مناقب الصحابة، مناقب الحسن والحسين (رضي الله عنهم)، ومسند أبي يعلى ٥/٢٢٨ ح ٢٨٤١، وغيرها من المصادر الكثيرة جداً.
١ - مجمع الزوائد ٩/١٩٥ كتاب المناقب، باب مناقب الحسين بن علي (عليهما السّلام)، المعجم الكبير ٥/٢٠٦، ٢١٠ في ما رواه ثابت بن مرداس عن زيد بن أرقم، تاريخ دمشق ١٤/٢٣٦ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، و٤١/٣٦٥ - ٣٦٦ في ترجمة علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الأخبار الطوال/٢٦٠ نهاية الحسين، فتح الباري ٧/٧٥، الوافي بالوفيات ١٢/٢٦٤ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب (رضي الله عنهم)، كنز العمال ١٣/٦٧٣ ح ٣٧٧١٧، ترجمة الإمام الحسين (عليه السّلام) من طبقات ابن سعد/٨٠ ح ٢٩٢، الفائق في غريب الحديث ١/٣٦٣ في مادة (دحج)، وغيرها من المصادر الكثيرة.
٢ - أسد الغابة ٥/٢٠ في ترجمة نضلة بن عبيد، تهذيب الكمال ٦/٤٢٨ - ٤٢٩ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، سير أعلام النبلاء ٣/٣٠٩ في ترجمة الحسين الشهيد، تاريخ دمشق ٦٢/٨٥ في ترجمة نضلة بن عبيد، تاريخ الطبري ٤/٢٩٣ أحداث سنة ستين من الهجرة، خروج الحسين (عليه السّلام) من مكة متوجّهاً إلى الكوفة، وص٣٥٦ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، الكامل في التاريخ ٤/٨٥ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، البداية والنهاية ٨/٢٠٩، ٢١٥ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، صفة مقتله مأخوذة من كلام أئمّة الشأن، الفتوح - لابن أعثم ٥/١٥٠ ذكر كتاب عبيد الله بن زياد إلى يزيد بن معاوية وبعثته إليه برأس الحسين بن علي (رضي الله عنهما)، مروج الذهب ٣/٧٢ مقتل الحسين (رضي الله عنه)، بغية الطلب في تاريخ حلب ٣/٣٨ في ترجمة الحسين بن علي بن عبد مناف أبي طالب، وغيرها من المصادر الكثيرة.
٣ - ترجمة الإمام الحسين (عليه السّلام) من طبقات ابن سعد/٨٢ ح ٢٩٦.
حتى إنّه (صلوات الله عليه) لما كتب إلى معاوية ينكر عليه جملة من موبقاته قيل لمعاوية: اكتب إليه كتاباً تعيبه وأباه فيه.
فقال: ما عسيت فيه أن أقول في أبيه إلّا أن أكذب! ومثلي لا يعيب أحداً بالباطل، وما عسيت أن أقول في حسين ولست أراه للعيب موضعاً...(١) .
الإمام الحسين (عليه السّلام) هو الرجل الأوّل في المسلمين
ومن أجل ذلك كلّه حاز المقام الأوّل في المسلمين، حيث يأتي عن شبث بن ربعي في حديث له عن قتل الإمام الحسين أنّه (عليه السّلام) خير أهل الأرض(٢) ، وعن معاوية أنّه (صلوات الله عليه) أحبّ الناس إلى الناس(٣) .
وفي حديث محمد بن الحنفية مع الإمام الحسين (عليه السّلام) قال: إنّي أخاف أن تدخل مصراً من هذه الأمصار وتأتي جماعة من الناس فيختلفون بينهم، فمنهم طائفة معك وأُخرى عليك؛ فيقتتلون فتكون لأوّل الأسنّة، فإذا خير هذه الأُمّة كلّها نفساً وأباً وأُمّاً، أضيعها دماً، وأذلّها أهلاً(٤) .
وورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنّ الإمام الحسين (عليه السّلام) مرّ على جماعة هو فيهم، فقال: ألا أخبركم بأحبّ أهل الأرض إلى أهل السماء؟ قالوا: بلى. قال: هو هذا الماشي. ما كلّمني كلمة منذ ليالي صفين، ولئن يرضى عنّي أحبّ إليّ من أن تكون لي حمر النعم(٥) .
____________________
١ - أنساب الأشراف ٣/٣٦٧ أمر الحسين بن علي بن أبي طالب.
٢ - يأتي في/١١١.
٣ - يأتي في/١٣٣ - ١٣٤.
٤ - تاريخ الطبري ٤/٢٥٣ أحداث سنة ستين من الهجرة، خلافة يزيد بن معاوية، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/١٦ - ١٧ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر بيعة يزيد.
٥ - تاريخ دمشق ٣١/٢٧٥ في ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص، واللفظ له، المعجم =
وفي حديث للفرزدق: هذا الحسين بن فاطمة الزهراء بنت محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا والله خيرة الله، وأفضل مَنْ مشى على الأرض من خلق الله...(١) .
وعنه أيضاً أنّه قال للإمام الحسين (عليه السّلام): أنت أحبّ الناس إلى الناس، والسيوف مع بني أُميّة، والقضاء في السماء(٢) .
وفي حديث لعبد الله بن مطيع مع الإمام الحسين (صلوات الله عليه) وهو في طريقه إلى مكّة قال له فيه: فالزم الحرم؛ فإنّك سيّد العرب في دهرك هذا...(٣) .
وقال ابن الأثير: فقال الناس لسنان بن أنس النخعي: قتلت الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! قتلت أعظم الناس خطراً...(٤) .
وقد قال مَنْ شقي بحمل رأسه الشريف مخاطباً أسياده الظالمين:
____________________
= الأوسط ٤/١٨١، مجمع الزوائد ٩/١٨٦ كتاب المناقب، باب مناقب الحسين بن علي (عليهما السّلام)، كنز العمال ١١/٣٤٣ ح ٣١٦٩٥، أسد الغابة ٣/٢٣٥ في ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص، وغيرها من المصادر.
١ - مقتل الحسين - للخوارزمي ١/٢٢٣ الفصل الحادي عشر، واللفظ له، الفتوح - لابن أعثم ٥/٨١ ذكر مسير الحسين (رضي الله عنه) إلى العراق، مطالب السؤول/٣٩٦ - ٣٩٧، كشف الغمّة ٢/٢٥٤.
٢ - تاريخ دمشق ٥٠/٢٨٥ - ٢٨٦ في ترجمة لبطة بن همام الفرزدق بن غالب، واللفظ له، و١٤/٢١٢ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، ترجمة الإمام الحسين (عليه السّلام) من طبقات ابن سعد/٦٢ ح ٢٨٤.
٣ - مقتل الحسين - للخوارزمي ١/١٨٩ الفصل التاسع، واللفظ له، الفتوح - لابن أعثم ٥/٢٥ ذكر وصية الحسين بن علي إلى أخيه محمد بن الحنفية، أنساب الأشراف ٣/٣٦٨ أمر الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام)، تاريخ الطبري ٤/٢٦١ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين (عليه السّلام)، الكامل في التاريخ ٤/١٩ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين (عليه السّلام)، الفصول المهمّة ٢/٧٥٨ الفصل الثالث، فصل في ذكر مخرجه (عليه السّلام) إلى العراق، وغيرها من المصادر.
٤ - الكامل في التاريخ ٤/٧٩ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، واللفظ له، تاريخ الطبري ٤/٣٤٧ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، أسد الغابة ٢/٢١ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، وغيرها من المصادر.
أوقرْ ركابي فضةً وذهبا |
إنّي قتلتُ السيّد المحجبا |
|
قتلتُ خيرَ الناسِ أُمّاً وأبا |
وخيرَهم إذ ينسبونَ نسبا(١) |
وقد جاء في كتاب عبد الله بن جعفر له (عليه السّلام) محاولاً صرفه عن المسير: أمّا بعد، فإنّي أسألك بالله لما انصرفت حين تقرأ كتابي هذا؛ فإنّي مشفق عليك من هذا الوجه أن يكون فيه هلاكك، واستئصال أهل بيتك. إنْ هلكت اليوم طُفئ نور الأرض؛ فإنّك علم المهتدين، ورجاء المؤمنين، فلا تعجل...(٢) .
وقال عبد الله بن مطيع: أُذكّرك الله - يابن رسول الله - وحرمة الإسلام أن تنتهك، أُنشدك الله في حرمة قريش، أُنشدك الله في حرمة العرب. فوالله لئن طلبت ما في أيدي بني أُميّة ليقتلنّك،، ولئن قتلوك لا يهابوا بعدك أحداً أبداً...(٣) .
وروى ابن سعد مسنداً قال: مرّ حسين بن علي على ابن مطيع، وهو ببئره
____________________
١ - الكامل في التاريخ ٤/٧٩ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، واللفظ له، مجمع الزوائد ٩/١٩٤ كتاب المناقب، باب مناقب الحسين بن علي (عليهما السّلام)، المعجم الكبير ٣/١١٧ - ١١٨ مسند الحسين بن علي، ذكر مولده وصفته ح ٢٨٥٢، الاستيعاب ١/٣٩٣ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، تاريخ دمشق ١٤/٢٥٢ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، أسد الغابة ٢/٢١ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، تهذيب الكمال ٦/٤٢٨ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، وغيرها من المصادر الكثيرة.
٢ - الكامل في التاريخ ٤/٤٠ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر مسير الحسين (عليه السّلام) إلى الكوفة، واللفظ له، تاريخ الطبري ٤/٢٩١ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مسير الحسين (عليه السّلام) من مكة متوجّهاً إلى الكوفة وما كان من أمره في مسيره، ومثله في البداية والنهاية ٨/١٨١ أحداث سنة ستين من الهجرة، صفة مخرج الحسين إلى العراق، إلّا أنّ فيه (نور الإسلام) بدل (نور الأرض)، وقريب منه في الفتوح - لابن أعثم ٥/٧٤ ابتداء أخبار الحسين بن علي (عليهما السّلام)، وغيرها من المصادر.
٣ - الإرشاد ٢/٧٢، واللفظ له، تاريخ الطبري ٤/٢٩٨ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مسير الحسين (عليه السّلام) من مكّة متوجّهاً إلى الكوفة وما كان من أمره في مسيره، الكامل في التاريخ ٤/٤١ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر مسير الحسين (عليه السّلام) إلى الكوفة، الفصول المهمّة ٢/٨٠٤ الفصل الثالث، فصل في ذكر مخرجه (عليه السّلام) إلى العراق، وغيرها من المصادر.
قد أنبطه، فنزل حسين عن راحلته، فاحتمله ابن مطيع احتمالاً حتى وضعه على سريره، ثمّ قال: بأبي وأُمّي، أمسك علينا نفسك؛ فوالله لئن قتلوك ليتّخذنا هؤلاء القوم عبيداً(١) .
وعنه أيضاً أنّه قال للإمام الحسين (عليه السّلام): ووالله لئن قُتلت لا بقيت حرمة بعدك إلّا استحلّت(٢) .
وبنظير ذلك صرّح الإمام الحسين (عليه السّلام) نفسه في المعركة حينما اشتدّ به الحال، فقد صاح بصوت عالٍ: «يا أُمّة السوء! بئسما خلفتم محمداً في عترته! أما إنّكم لن تقتلوا بعدي عبداً من عباد الله الصالحين فتهابوا قتله، بل يهون عليكم عند قتلكم إيّاي...»(٣) .
وقال (عليه السّلام) أيضاً: «أما والله، لا تقتلون بعدي عبداً من عباد الله، الله أسخط عليكم لقتله منّي»(٤) ... إلى غير ذلك.
ويؤكّد ما ذكرنا أنّ عبد الله بن الزبير كان شديد البغض لبني هاشم والتحامل عليهم حتى إنّه قال لابن عباس: إنّي لأكتم بغضكم أهل هذا البيت منذ أربعين سنة(٥) ، وقد ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته، فقيل له
____________________
١ - الطبقات الكبرى ٥/١٤٥ في الحديث عن عبد الله بن مطيع، واللفظ له، بغية الطلب في تاريخ حلب ٦/٢٦٠٨.
٢ - العقد الفريد ٤/٣٤٤ فرش كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم، خلافة يزيد بن معاوية وسنه وصفته، مقتل الحسين بن علي (رضي الله عنه)، واللفظ له، المحاسن والمساوئ ١/٢٦ مساوئ قتلة الحسين بن علي (رضوان الله عليهما).
٣ - مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٣٤، واللفظ له، الفتوح - لابن أعثم ٥/١٣٥ تسمية من قتل بين يدي الحسين من ولده وإخوانه وبني عمّه (رضي الله عنهم).
٤ - تاريخ الطبري ٤/٣٤٦ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/٧٨ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، البداية والنهاية ٨/٢٠٤ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، صفة مقتله مأخوذة من كلام أئمّة الشأن، وغيرها من المصادر.
٥ - مروج الذهب ٣/٩٠ ذكر أيام معاوية بن يزيد بن معاوية ومروان بن الحكم، والمختار بن أبي عبيد وعبد الله بن الزبير، ولمع من أخبارهم وسيرهم وبعض ما كان من أيامهم، بين عبد الله بن عباس (رضي الله عنهم) وعبد الله بن الزبير (رضي الله عنهم)، واللفظ له، شرح نهج البلاغة ٤/٦٢، و٢٠/١٤٨، سمط النجوم العوالي ٣/١٢٥ شأن المختار مع ابن الزبير، وغيرها من المصادر. =
في ذلك فقال: إنّ له أهل سوء يشرئبون لذكره، ويرفعون رؤوسهم إذا سمعوا به(١) ، وكان ينال من أمير المؤمنين (عليه السّلام)(٢) .
حتى إنّه لما عزّى عبد الله بن عباس بالإمام الحسين (عليه السّلام) ثمّ انصرف، قال ابن عباس: إنّه ليعدل عندي مصيبة الحسين شماتة ابن الزبير، أترون مشي ابن الزبير إليّ يعزّيني؟! إن ذلك منه إلّا شماتة(٣) .
ومع كلّ ذلك كان يعرف هو وغيره أنّه لا يستطيع طلب البيعة لنفسه والإمام الحسين (صلوات الله عليه) في الحرم حتى اتّهمه الناس في مشورته على الإمام الحسين (عليه السّلام) بالخروج إلى العراق(٤) .
____________________
= وروى ابن أعثم أنّ ابن الزبير قال: ولقد كتمتم بغضكم يا بني هاشم أربعين سنة. فقال ابن عباس: فازدد إذاً بي غضباً فوالله لا نبالي أحببتنا أم أبغضتنا.... ونبّه المحقق في الهامش إلى أنّه ورد في الأصل بدل (كتمتم)، كتمت. وهو الصحيح بملاحظة تتمّة الرواية، الفتوح - لابن أعثم ٦/٣٦٤ - ٣٦٥ ذكر ما جرى بين عبد الله بن عباس وابن الزبير في أمر محمد بن الحنفية.
١ - تاريخ اليعقوبي ٢/٢٦١ أيام مروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير وأيام من أيام عبد الملك، واللفظ له، ومثله مع اختلاف يسير في أنساب الأشراف ٥/٣٣٣ أمر عمرو بن لزبير بن العوام ومقتله، و٧/١٣٣ أمر عبد الله بن الزبير في أيام عبد الملك ومقتله، والعقد الفريد ٤/٣٧٧ مقتل مصعب بن الزبير، ومروج الذهب ٣/٩٠ بعد حديثه عن الكيسانية، وشرح نهج البلاغة ٤/٦٢، و١٩/٩٢، و٢٠/١٢٨، وقريب منه في سمط النجوم العوالي ٣/١٢٥ شأن المختار مع ابن الزبير.
٢ - تاريخ اليعقوبي ٢/٢٦١ - ٢٦٢ أيام مروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير وأيام من أيام عبد الملك، جمهرة خطب العرب ٢/٩٠ خطبة محمد بن الحنفية يرد على عبد الله بن الزبير وقد تنقص الإمام، مروج الذهب ٣/٩٠ بين ابن الحنفية وابن الزبير، شرح نهج البلاغة ٤/٦٢، وغيرها من المصادر.
٣ - تاريخ دمشق ١٤/٢٣٩ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، واللفظ له، تهذيب الكمال ٦/٤٤٠ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، ترجمة الإمام الحسين (عليه السّلام) من طبقات ابن سعد/٨٦ ح ٢٩٨.
٤ - تقدّمت مصادره في/١٣.
وقال الإمام (عليه السّلام): «إنّ هذا ليس شيء من الدنيا أحبّ إليه من أن أخرج من الحجاز، وقد علم أنّ الناس لا يعدلونه بي، فودّ أنّي خرجت حتى يخلو له»(١) .
بل ورد أنّ ابن الزبير قال للإمام الحسين (صلوات الله عليه): أما إنّك لو أقمت بالحجاز، ثمّ أردت هذا الأمر ههنا لما خالفنا عليك، وبايعناك ونصحنا لك(٢) ، وقال له: أقم في هذا المسجد أجمع لك الناس(٣) .
كلّ ذلك لما ذكرناه من أنّ الإمام الحسين (صلوات الله عليه) كان هو الرجل الأوّل في المسلمين، ولا يتقدّم عليه غيره.
وبذلك كان الإقدام على قتله وانتهاك حرمته هو الجريمة الكبرى التي قام بها الأمويون في الواقعة، والمصيبة العظمى التي حلّت بالمؤمنين والمسلمين.
وقد زاد في بشاعة هذه الجريمة أنّه (صلوات الله عليه) لم يُقتل مواجهة في المعركة، وإنّما قُتل ذبحاً صبراً، بعد أن ضعف عن القتال، وأعياه نزف الدم، فبقي على وجه الأرض طويلاً(٤) .
____________________
١ - الكامل في التاريخ ٤/٣٨ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر مسير الحسين (عليه السّلام) إلى الكوفة، واللفظ له، تاريخ الطبري ٤/٢٨٨ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مسير الحسين (عليه السّلام) من مكة متوجّهاً إلى الكوفة وما كان من أمره في مسيره، الفصول المهمّة ٢/٧٩٨ الفصل الثالث، فصل في ذكر مخرجه (عليه السّلام) إلى العراق، وغيرها من المصادر.
٢ - الكامل في التاريخ ٤/٣٨ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر مسير الحسين (عليه السّلام) إلى الكوفة، واللفظ له، تاريخ الطبري ٤/٢٨٨ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مسير الحسين (عليه السّلام) من مكة متوجّهاً إلى الكوفة وما كان من أمره في مسيره.
٣ - تاريخ الطبري ٤/٢٨٩ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مسير الحسين (عليه السّلام) من مكة متوجّهاً إلى الكوفة وما كان من أمره في مسيره، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/٣٨ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر مسير الحسين (عليه السّلام) إلى الكوفة.
٤ - تاريخ الطبري ٤/٣٤٦ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، الكامل في التاريخ ٤/٧٨ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، سير أعلام النبلاء ٣/٣٠٢ في ترجمة الحسين الشهيد، البداية والنهاية ٨/٢٠٤ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة: صفة =
وقد أُضيف إلى هذه الجريمة النكراء جرائم وانتهاكات زادت في مأساوية الفاجعة:
جريمة قتل أهل البيت (عليهم السّلام) الذين معه
الأوّل: قتل مَنْ كان مع الحسين (صلوات الله عليه) من أولاده وإخوته وبني عمومته من آل أبي طالب الذين هم أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخصهم به، بحيث يكون وجودهم بقاء له ومذكّراً به.
خصوصاً وإنّ فيهم مَنْ يشبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقد ورد أنّه لما برز علي بن الحسين الأكبر (عليهم السّلام) قال الإمام الحسين (صلوات الله عليه): «اللّهمّ اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقاً وخلقاً ومنطقاً برسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكنّا إذا اشتقنا إلى وجه رسولك نظرنا إلى وجهه...»(١) .
ثمّ رفع (عليه السّلام) صوته وقرأ:( إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ * ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (٢) .
هذا مضافاً إلى ما تحظى به هذه الثلّة الكريمة من مقام رفيع عند المسلمين، حيث الدين والخلق السامي والشرف والسؤدد.
وقد وصفتهم العقيلة زينب الكبرى بقولها في خطبتها في مجلس يزيد: بإراقتك دماء ذرية آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونجوم الأرض من آل عبد المطلب(٣) .
____________________
= مقتله مأخوذة من كلام أئمّة الشأن، وغيرها من المصادر الكثيرة.
١ - مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٣٠، واللفظ له، بحار الأنوار ٤٥/٤٢ - ٤٣، اللهوف في قتلى الطفوف/٦٧، ومثله مع اختلاف يسير في الفتوح - لابن أعثم ٥/١٣٠ تسمية من قتل بين يدي الحسين من ولده وإخوانه وبني عمّه (رضي الله عنهم)، ومقاتل الطالبيين/٧٧ مقتل الحسين بن علي (عليه السّلام).
٢ - سورة آل عمران/٣٣ - ٣٤.
٣ - راجع ملحق رقم ٤.
ووصفهم ابن عباس في كتابه إلى يزيد بقوله: وقد قتلت حسيناً وفتيان عبد المطلب، مصابيح الدجى، ونجوم الهدى، وأعلام التقى(١) .
وفي حديث الريان بن شبيب عن الإمام الرضا (صلوات الله عليه) قال: وقُتل معه من أهل بيته ثمانية عشر رجلاً ما لهم في الأرض شبيه(٢) .
وعن الحسن البصري أنّه قال: قُتل مع الحسين بن علي ستة عشر من أهل بيته ما كان لهم على وجه الأرض شبيه(٣) .
وعن منذر أنّه قال: كنّا إذا ذكرنا الحسين بن علي ومَنْ قُتل معه، قال محمد بن الحنفية: قد قتلوا سبعة عشر شاباً كلّهم قد ارتكضوا في رحم فاطمة(٤) .
وعن الربيع بن خيثم أنّه قال: لقد قتلوا فتية لو رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
____________________
١ - مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٧٨، واللفظ له، وقريب منه في مجمع الزوائد ٧/٢٥١ كتاب الفتن، باب فيما كان من أمر ابن الزبير ويزيد بن معاوية واستخلاف أبيه وغير ذلك، والمعجم الكبير ١٠/٢٤٢ باب أحاديث عبد الله بن عباس، ومن مناقب عبد الله بن عباس وأخباره، والكامل في التاريخ ٤/١٢٨ أحداث سنة أربع وستين من الهجرة، ذكر بعض سيرة يزيد بن معاوية وأخباره، وتاريخ اليعقوبي ٢/٢٤٨ مقتل الحسين بن علي، وأنساب الأشراف ٥/٣٢٢ أمر عبد الله بن الزبير بعد مقتل الحسين، وغيرها من المصادر الكثيرة.
٢ - الأمالي - للصدوق/١٩٢ المجلس السابع والعشرون، واللفظ له، عيون أخبار الرضا ٢/٢٦٨، إقبال الأعمال ٣/٢٩، بحار الأنوار ٩٨/١٣٠، وغيرها من المصادر.
٣ - مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٤٧، واللفظ له، الاستيعاب ١/٣٩٦ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، العقد الفريد ٤/٣٥٠ فرش كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم، مقتل الحسين بن علي. تاريخ خليفة بن خياط/١٧٩ أحداث سنة إحدى وستين. ذخائر العقبى/١٤٦ مقتل الحسين وذكر قاتله، نظم درر السمطين/٢١٨، وغيرها من المصادر.
٤ - ترجمة الإمام الحسين من طبقات ابن سعد/٨٧ ح ٣٠٥، واللفظ له، المعجم الكبير، مسند الحسين بن علي، ذكر مولده وصفته ٣/١٠٤ ح ٢٨٠٥، وص ١١٩ ح ٢٨٥٥، مجمع الزوائد ٩/١٩٨ كتاب المناقب، باب مناقب الحسين بن علي، الوافي بالوفيات ١٢/٢٦٥ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، وغيرها من المصادر.
لأحبّهم، وأطعمهم بيده، وأجلسهم على فخذه(١) . وقال أيضاً: لقد قتلوا صبية لو أدركهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأجلسهم في حجره، ولوضع فمه على أفمامهم(٢) .
وقال لأشياخ من أهل الكوفة أتوه ليعرفوا رأيه في قتل الإمام الحسين (صلوات الله عليه): أرأيتم لو أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكوفة وفيها أحد من أهل بيته فيمَنْ كان ينزل؟!(٣) .
هذا مضافاً إلى ما ورد عن بعضهم من النكات المضيئة الشاهدة بشرف نفوسهم ورفعة مقامهم وقوّة بصائرهم.
فعن عقبة بن سمعان أنّه قال: فلمّا ارتحلنا من قصر بني مقاتل، وسرنا ساعة خفق الحسين برأسه خفقة، ثمّ انتبه وهو يقول: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون، والحمد لله ربّ العالمين». ففعل ذلك مرّتين أو ثلاث. قال: فأقبل إليه ابنه علي بن الحسين على فرس له، فقال: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، والحمد لله ربّ العالمين. يا أبتِ جُعلت فداك! ممّ حمدت الله واسترجعت؟ قال: «بُني إنّي خفقت برأسي خفقة، فعنّ لي فارس على فرس، فقال: القوم يسيرون والمنايا تسري إليهم؛ فعلمت أنّها أنفسنا نُعيت إلينا». قال له: يا أبتِ لا أراك الله سوء! ألسنا على الحقّ؟ قال: «بلى والذي إليه مرجع العباد». قال: يا أبتِ إذاً لا نبالي، نموت محقّين. فقال له: «جزاك الله من ولد خير ما جزى ولداً عن والده»(٤) .
____________________
١ - تذكرة الخواص/٢٦٨ ذكر قول أُمّ سلمة والحسن البصري والربيع بن خيثم وغيرهم، واللفظ له، مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٤٤.
٢ - ترجمة الإمام الحسين من طبقات ابن سعد/٨٧ ح ٣٠٤، واللفظ له، تفسير الثعلبي ٨/٢٣٩ في تفسير قوله تعالى:( اللّهمّ فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة... ) من سورة الزمر.
٣ - ترجمة الإمام الحسين من طبقات ابن سعد/٨٧ ح ٣٠٣.
٤ - تاريخ الطبري ٤/٣٠٨ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/٥١ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، الإرشاد ٢/٨٢، إعلام الورى بأعلام الهدى ١/٤٥٠، وغيرها من المصادر.
وفي اليوم التاسع من المحرّم نادى الشمر: بنو أختي عبد الله وجعفر والعباس وعثمان. فأعرضوا عنه. فقال لهم الإمام الحسين (عليه السّلام): «أجيبوه وإن كان فاسقاً...». فقالوا له: ما شأنك؟ قال: يا بني أختي أنتم آمنون. فلا تقتلوا أنفسكم مع أخيكم الحسين، والزموا طاعة أمير المؤمنين يزيد(١) . فقالوا له: لعنك الله ولعن أمانك لئن كنت خالنا! أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟!(٢) ، أتأمرنا أن نترك سيّدنا وأخانا وندخل في طاعة اللعناء وأولاد اللعناء؟!(٣) .
وهم بهذا العدد قد خلت بيوتهم من الرجال وأوحشت، ولم يبقَ فيها إلّا نساء وأطفال يهيجون العواطف ويستثيرون الأسى والنقمة.
قتل الثلّة الصالحة من أصحاب الحسين (عليه السّلام) معه
الثاني: قتل الثلّة الصالحة من أصحاب الإمام الحسين (عليه السّلام)، وفيهم الصحابة، والقرّاء، والمعروفون بالدين والورع، والأثر الحميد في الإسلام، والمواقف المشرّفة فيه (رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم).
____________________
١ - هكذا ورد النص في اللهوف في قتلى الطفوف/٥٤، وقريب منه في بقية المصادر الآتية في الهامش التالي.
٢ - تاريخ الطبري ٤/٣١٥ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/٥٦ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، تذكرة الخواص/٢٤٩ الباب التاسع في ذكر الحسين (عليه السّلام)، ذكر وصول الحسين (عليه السّلام) إلى العراق، الفتوح - لابن أعثم ٥/١٠٤ - ١٠٥ ذكر اجتماع العسكر إلى حرب الحسين بن علي (رضي الله عنه)، وغيرها من المصادر.
٣ - مثير الأحزان/٢٨ واللفظ له، اللهوف في قتلى الطفوف/٥٤.
وروي أنّ ابن زياد كتب لهم أماناً فلمّا رأوا الكتاب قالوا: لا حاجة لنا في أمانكم، أمان الله خير من أمان ابن سمية. لاحظ تاريخ الطبري ٤/٣١٤ - ٣١٥ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، الكامل في التاريخ ٤/٥٦ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، والبداية والنهاية ٨/١٩٠ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، صفة مقتله مأخوذة من كلام أئمّة الشأن، وغيرها من المصادر.
وقد قال الإمام الحسين (عليه السّلام) لهم ليلة العاشر من المحرّم: «أمّا بعد، فإنّي لا أعلم أصحاباً أوفى ولا أخير من أصحابي، ولا أهل بيت أبرّ ولا أوصل من أهل بيتي»(١) .
وقال عمرو بن الحجّاج عنهم في المعركة مخاطباً عسكر ابن سعد: ويلكم يا حمقاء مهلاً! أتدرون لِمَنْ تقاتلون؟! إنّما تقاتلون فرسان المصر، وأهل البصائر، وقوماً مستميتين...(٢) .
وقال حبيب بن مظاهر مخاطباً عسكر ابن سعد واعظاً لهم: أما والله، لبئس القوم عند الله غداً قوم يقدمون عليه قد قتلوا ذريّة نبيه (عليه السّلام) وعترته وأهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم، وعباد أهل هذا المصر، المجتهدين بالأسحار، والذاكرين الله كثيراً. فقال له عزرة بن قيس: إنّك لتزكّي نفسك ما استطعت. فقال له زهير بن القين: يا عزرة، إنّ الله قد زكّاها وهداه، فاتقِ الله يا عزرة؛ فإنّي لك من الناصحين. أُنشدك الله يا عزرة أن تكون ممّنْ يعين الضلال على قتل النفوس الزكية(٣) .
وفي حديث غلام عبد الرحمن بن عبد ربّه الأنصاري قال: فجعل برير يهازل عبد الرحمن، فقال له عبد الرحمن: دعنا، فوالله ما هذه بساعة باطل. فقال
____________________
١ - الكامل في التاريخ ٤/٥٧ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، واللفظ له، تاريخ الطبري ٤/٣١٧ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، الفتوح - لابن أعثم ٥/١٠٥ ذكر اجتماع العسكر إلى حرب الحسين بن علي (رضي الله عنه)، ينابيع المودّة ٣/٦٥، مقتل الحسين - للخوارزمي ١/٢٤٧ الفصل الحادي عشر، الأمالي - للصدوق/٢٢٠ المجلس الثلاثون، الإرشاد ٢/٩١، اللهوف في قتلى الطفوف/٥٥، وغيرها من المصادر.
٢ - مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/١٥، واللفظ له، تاريخ الطبري ٤/٣٣١ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، الكامل في التاريخ ٤/٦٧ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، أنساب الأشراف ٣/٤٠٠ مقتل الحسين بن علي (عليهم السّلام)، وغيرها من المصادر.
٣ - تاريخ الطبري ٤/٣١٦ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، واللفظ له، الفتوح - لابن أعثم ٥/١٠٩ ذكر اجتماع العسكر إلى حرب الحسين بن علي (رضي الله عنه).
له برير: والله لقد علم قومي أنّي ما أحببت الباطل شاباً ولا كهلاً، ولكن والله إنّي لمستبشر بما نحن لاقون، والله إنّ بيننا وبين الحور العين إلّا أن يميل هؤلاء علينا بأسيافهم...(١) .
ولمّا ذهب كعب بن جابر الأزدي ليحمل على برير قال له عفيف بن زهير بن أبي الأخنس رادعاً له: إنّ هذا برير بن خضير القارئ الذي كان يُقرئنا القرآن في المسجد.
ولمّا قتله ورجع إلى الكوفة قالت له امرأته أو أخته النوار بنت جابر: أعنت على ابن فاطمة، وقتلت سيّد القرّاء! لقد أتيت عظيماً من الأمر! والله لا أكلمك من رأسي كلمة أبداً(٢) .
ولمّا حمل عمرو بن الحجّاج بأصحابه على أصحاب الحسين (عليه السّلام) وصرع مسلم بن عوسجة، قال أصحاب عمرو بن الحجّاج متبجّحين: قتلنا مسلم بن عوسجة الأسدي. فقال شبث بن ربعي: ثكلتكم أُمّهاتكم! تفرحون أن يُقتل مثل مسلم بن عوسجة؟! أما والذي أسلمت له لرُبّ موقف له قد رأيته في المسلمين كريم، لقد رأيته يوم سلق آذربايجان قتل ستة من المشركين قبل تتام خيول المسلمين، أفيقتل منكم مثله وتفرحون؟!(٣) .
وقال أبو ثمامة عمرو بن عبد الله الصائدي للإمام الحسين (عليه السّلام): يا أبا عبد
____________________
١ - تاريخ الطبري ٤/٣٢١ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/٦٠ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، البداية والنهاية ٨/١٩٣ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، صفة مقتله مأخوذة من كلام أئمّة الشأن، وغيرها من المصادر.
٢ - تاريخ الطبري ٤/٣٢٩ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، واللفظ له، وذكر بعضه في الكامل في التاريخ ٤/٦٧ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، وأنساب الأشراف ٣/٣٩٩ مقتل الحسين بن علي (عليهم السّلام)، وغيرها من المصادر.
٣ - تاريخ الطبري ٤/٣٣٢ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/٦٧ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه).
الله نفسي لك الفداء! إنّي أرى هؤلاء قد اقتربوا منك، ولا والله لا تُقتل حتى أُقتل دونك إن شاء الله، وأحبّ أن ألقى ربّي وقد صلّيت هذه الصلاة التي قد دنا وقتها. فرفع الإمام الحسين (عليه السّلام) رأسه، ثمّ قال: «ذكرت الصلاة! جعلك الله من المصلّين الذاكرين. نعم، هذا أوّل وقتها»(١) ... إلى غير ذلك ممّا يشهد بما ذكرنا من رفيع مقامهم (رضوان الله تعالى عليهم).
قتل الأطفال بما فيهم الرضيع
الثالث: قتل الأطفال الأبرياء العزّل(٢)
____________________
١ - تاريخ الطبري ٤/٣٣٤ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/٧٠ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/١٧.
٢ - قال هاني بن ثبيت الحضرمي: إنّي لواقف عاشر عشرة ليس منّا رجل إلّا على فرس وقد جالت الخيل وتصعصعت، إذ خرج غلام من آل الحسين وهو ممسك بعود من تلك الأبنية عليه إزار وقميص، وهو مذعور يتلفّت يميناً وشمالاً، فكأنّي أنظر إلى درّتين في أُذنيه تذبذبان كلّما التفت، إذ أقبل رجل يركض حتى إذا دنا منه مال عن فرسه ثمّ اقتصد الغلام فقطعه بالسيف...، تاريخ الطبري ٤/٣٤٣ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، البداية والنهاية ٨/٢٠٢ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، صفة مقتله مأخوذة من كلام أئمّة الشأن، مقاتل الطالبيين/٧٩ مقتل الحسين بن علي (عليه السّلام).
وقال ابن طاووس: فخرج عبد الله بن الحسن (عليه السّلام) وهو غلام لم يراهق من عند النساء يشتدّ حتى وقف إلى جنب الحسين، فلحقته زينب بنت علي (عليه السّلام) لتحبسه، فأبى وامتنع امتناعاً شديداً، فقال: لا والله، لا أفارق عمّي. فأهوى بحر بن كعب - وقيل: حرملة بن كاهل - إلى الحسين (عليه السّلام) بالسيف، فقال الغلام: ويلك يابن الخبيثة أتقتل عمّي؟! فضربه بالسيف، فاتّقاه الغلام بيده فأطنها إلى الجلد، فإذا هي معلّقة. فنادى الغلام: يا أُمّاه، فأخذه الحسين (عليه السّلام) وضمّه إليه، وقال: «يابن أخي، اصبر على ما نزل بك واحتسب في ذلك الخير؛ فإنّ الله يلحقك بآبائك الصالحين». قال: فرماه حرملة بن كاهل =
بما فيهم الرضيع(١) .
____________________
= بسهم فذبحه وهو في حجر عمّه الحسين (عليه السّلام)، اللهوف في قتلى الطفوف/٧١، واللفظ له، ومثله في الإرشاد ٢/١١٠، ومقاتل الطالبيين/٧٧ مقتل الحسين بن علي (عليه السّلام)، وتاريخ الطبري ٤/٣٤٤ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، والكامل في التاريخ ٤/٧٧ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، وغيرها من المصادر.
وقال ابن سعد: وقد كان ابنا عبد الله بن جعفر لجئا إلى امرأة عبد الله بن قطبة الطائي، ثمّ النبهاني، وكانا غلامين لم يبلغا، وقد كان عمر بن سعد أمر منادياً فنادى: مَنْ جاء برأس فله ألف درهم. فجاء ابن قطبة إلى منزله، فقالت له امرأته: إنّ غلامين لجئا إلينا، فهل لك أن تشرف بهم، فتبعث بهما إلى أهلهما بالمدينة؟ قال: نعم أرينهم، فلّما رآهما ذبحهم، وجاء برؤوسهما إلى عبيد الله بن زياد...، ترجمة الإمام الحسين (عليه السّلام) من طبقات ابن سعد/٧٧ ح ٢٩٢. وقد ذكر بتفصيل في مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٤٨ - ٥٢، ولكن ذكر أنّهما من ولد جعفر الطيّار في الجنة، وذكره كذلك عن المناقب القديم في بحار الأنوار ٤٥/١٠٠ - ١٠٧. وذكره بتفصيل أكثر الشيخ الصدوق في أماليه المجلس التاسع عشر/١٤٣ - ١٤٥، ولكن ذكر أنّهما ولدان لمسلم بن عقيل (عليه السّلام)، وهو المعروف اليوم، ولهما مشهد يُزار.
(١) الفتوح - لابن أعثم ٥/١٣١ تسمية مَنْ قُتل بين يدي الحسين من ولده وإخوانه وبني عمّه (رضي الله عنهم)، ينابيع المودةّ ٣/٧٩.
قال ابن طاووس: وقال لزينب: «ناوليني ولدي الصغير؛ حتى أودّعه»، فأخذه وأومأ إليه ليقبّله فرماه حرملة بن كاهل الأسدي (لعنه الله) بسهم فوقع في نحره فذبحه، فقال لزينب: «خذيه»، ثمّ تلقى الدم بكفيه، فلمّا امتلأتا رمى بالدم نحو السماء، قال: «هوّن ما نزل بي أنّه بعين الله». قال الباقر (عليه السّلام): «فلم يسقط من ذلك الدم قطرة إلى الأرض». اللهوف في قتلى الطفوف/٦٩، واللفظ له، مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٣٢.
وورد قتل الطفل الصغير في حجر الإمام الحسين (عليه السّلام) في تاريخ الطبري ٤/٣٤٢ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، والكامل في التاريخ ٤/٧٥ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، والإرشاد ٢/١٠٨، وغيرها من المصادر.
وقال اليعقوبي: فإنّه لواقف على فرسه إذ أتي بمولود قد ولد في تلك الساعة، فأذّن في أذنه، وجعل يحنّكه إذ أتاه سهم، فوقع في حلق الصبي فذبحه، فنزع الحسين السهم من حلقه، وجعل يلطخه بدمه، ويقول: «والله، لأنت أكرم على الله من الناقة، ولمحمد أكرم على الله من صالح...». تاريخ اليعقوبي ٢/٢٤٥ مقتل الحسين بن علي.
وكذا بعض النساء من دون أن يُقاتلنَ(١) ، حيث يكشف ذلك عن ثقافة إجرامية ووحشية مقزّزة.
التضييق على ركب الإمام الحسين (عليه السّلام) ومنعهم من الماء
الرابع: التضييق على الإمام الحسين (عليه السّلام) وأهل بيته وأصحابه ومنعهم من الماء حتى أضرّ بهم العطش، تذرعاً بالانتقام لعثمان، مع أنّ من المعلوم للجميع أنّ أهل البيت (صلوات الله عليهم) أبرأ الناس من دمه، وأسمى من أن يمنعوه الماء.
ولاسيما أنّ الإمام الحسين (صلوات الله عليه) نفسه قد سقى الحرّ وأصحابه حينما التقى بهم في الطريق، وهم قد جاؤوا ليأخذوه أسيراً لابن زياد(٢) .
كما إنّ من المعروف أنّ أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) لم يَجزِ معاوية وعسكره في حرب صفين بالمثل، فلم يمنعهم الماء في حرب صفين، وإن سبق منهم منعه ومنع عسكره من الماء لما استولوا عليه.
انتهاك حرمة العائلة النبويّة
الخامس: انتهاك حرمة العائلة النبويّة الكريمة، ذات المكانة العالية في النفوس، والمعروفة بالخدر والحشمة؛ سواء في المعركة(٣) أم بعدها، وذلك
____________________
١ - فقد خرجت امرأة الكلبي تمشي إلى زوجه، فجلست عند رأسه تمسح التراب عن وجهه، وتقول: هنيئاً لك الجنة. فأمر شمر غلاماً اسمه رستم فضرب رأسها بالعمود فشدخه فماتت مكانها. الكامل في التاريخ ٤/٦٩ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، واللفظ له، تاريخ الطبري ٤/٣٣٣ - ٣٣٤ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/١٣، لكن الموجود فيه أنّ المقتولة أُمّ وهب الكلبي، وأنّها أوّل امرأة قُتلت في حرب الحسين (عليه السّلام)، وظاهره قتل نساء أُخر.
٢ - تقدّمت مصادره في/٣٠ - ٣١.
٣ - تاريخ الطبري ٤/٣٣٣ - ٣٣٤ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، الكامل في التاريخ ٤/٦٩
بإرعابها وبحرق خيامها، وسلبها، والتشهير بها وتسييرها في البلدان، بوجه تقشعرّ له الأبدان.
انتهاك حرمة الأجساد الشريفة بعد القتل
السادس: انتهاك حرمة الأجساد الشريفة بعد القتل بسلب الإمام الحسين (صلوات الله عليه)، ورضّ جسده الشريف بالخيل، وترك جسده وأجساد مَنْ قُتل معه بالعراء من دون دفن، وقطع الرؤوس ورفعها على الرماح والتشهير بها في البلدان... إلى غير ذلك من مظاهر الانحطاط والوحشية التي هي سمة الطغاة والجبابرة والمعقّدين، الذين خرجوا في مفاهيمهم وسلوكهم عن ضوابط الإنسانية القويمة، وأوقعوا بالمجتمع الإنساني في عصوره المختلفة وحتى عصرنا الحاضر صنوف المصائب والفواجع والجرائم المقزّزة والمغرقة في الوحشية.
النيل من الإمام الحسين (عليه السّلام) وأهل بيته
السابع: النيل من الإمام الحسين وأهل بيته وأسلافه الطاهرين (صلوات الله عليهم) على المنابر وفي المحافل(١) ؛ من أجل إسقاط حرمتهم، وبيان شرعية
____________________
أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/١٦.
(١) مثل ما يأتي في خطبة ابن زياد في مسجد الكوفة، قوله للعقيلة زينب الكبرى (عليها السّلام) في مجلسه: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم، و: قد أشفى الله نفسي من طاغيتك والعصاة المردة من أهل بيتك. تاريخ الطبري ٤/٣٤٩ - ٣٥٠ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/٨١ - ٨٢ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، البداية والنهاية ٨/٢١٠ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، صفة مقتله مأخوذة من كلام أئمّة الشأن، إلّا أنّه لم يخرج إلّا المقطع الأوّل من كلام ابن زياد، وغيرها من المصادر.
وقول يزيد للعقيلة زينب (عليه السّلام): إنّما خرج من الدين أبوك وأخوك. تاريخ الطبري =
قتلهم وما فعلوه بهم. مع أنّهم (صلوات الله عليهم) بالمكان الرفيع من الاحترام والتقديس.
كلّ ذلك أضاف للجريمة الكبرى بقتل الإمام الحسين (صلوات الله عليه) بعداً إجرامياً كبيراً، واقعياً وعاطفياً.
____________________
= ٤/٣٥٣ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/٨٦ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، البداية والنهاية ٨/٢١٢ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، صفة مقتله مأخوذة من كلام أئمّة الشأن، الأمالي - للصدوق/٢٣١ المجلس الحادي والثلاثون، الإرشاد ٢/١٢١، وغيرها من المصادر الكثيرة.
وما عن الإمام زين العابدين (عليه السّلام) قال: «حتى إذا أدخلنا دمشق صاح صائح: يا أهل الشام، هؤلاء سبايا أهل البيت الملعون». إقبال الأعمال ٣/٨٩، بحار الأنوار ٤٥/١٥٤.
وذلك هو المناسب لموقف الأمويين من أهل البيت (صلوات الله عليهم) حيث عمم معاوية ومن بعده لعن أمير المؤمنين (عليه السلام) على منابر المسلمين. وقال أبو يحيى زياد المكي: «كنت بين الحسن بن علي والحسين ومروان بن الحكم، والحسين يساب مروان. فجعل الحسن ينهى الحسين، حتى قال مروان: إنكم أهل بيت ملعونون. قال: فغضب الحسن، وقال: ويلك! قلت أهل بيت ملعونين. فوالله لقد لعن الله أباك وأنت في صلبه». ترجمة الإمام الحسين (عليه السلام) من طبقات ابن سعد ص: ٣٥ - ٣٦، واللفظ له. مسند أبي يعلى ج: ١٢ ص ١٣٥ مسند الحسن بن علي بن أبي طالب. المعجم الكبير ج: ٣ ص ٨٥ في ما رواه أبو يحيى الأعرج عن الحسن بن علي رضي الله عنه. المطالب العالية ج: ١٨ ص: ٢٦٥، ٢٦٦ كتاب الفتن: باب لعن رسول الله صلّى الله عليه وآله الحكم بن العاص وبنيه وبني ابنه. مجمع الزوائد ج: ٥ ص: ٢٤٠ كتاب الخلافة: باب في أئمة الظلم والجور وأئمة الضلالة، ج: ١٠ ص: ٧٢ كتاب المناقب: باب في من ذم من القبائل وأهل البدع. سير أعلام النبلاء ج:٣ ص: ٤٧٨ في ترجمة مروان بن الحكم. تاريخ الإسلام ج:٣ ص: ٣٦٦ في أحداث سنة إحدى وثلاثين من الهجرة، ج: ٥ ص: ٢٣٢ في ترجمة مروان بن الحكم. تاريخ دمشق ج: ٥٧ ص: ٢٤٤، ٢٤٥ في ترجمة مروان بن الحكم بن أبي العاص. كنز العمال ج:١١ ص: ٣٥٧ ح: ٣١٧٣٠. وغيرها من المصادر.
وما يأتي في الملحق الخامس من أمره بمنبر وخطيب يقع في الإمامين أمير المؤمنين والحسين (عليهم السّلام) فأكثر الوقيعة فيهم... إلى غير ذلك ممّا يظهر للمتتبع.
وزاد في البعد الإجرامي للواقعة وتأثيرها على المجتمع الإسلامي أمور:
الإمام الحسين (عليه السلام) بقية أصحاب الكساء
الأوّل: إنّ الإمام الحسين (عليه السّلام) كان بقيّة أصحاب الكساء (صلوات الله عليهم)، فانقطع بقتله أثرهم، كما تضمّن ذلك ما رواه الصدوق بسنده عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال:
قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليه السّلام): يابن رسول الله، كيف صار يوم عاشوراء يوم مصيبة وغم وجزع وبكاء، دون اليوم الذي قُبض منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واليوم الذي ماتت فيه فاطمة (عليها السّلام)، واليوم الذي قُتل فيه أمير المؤمنين (عليه السّلام)، واليوم الذي قُتل فيه الحسن (عليه السّلام) بالسم؟
فقال: «إنّ يوم الحسين (عليه السّلام) أعظم مصيبة من جميع سائر الأيام؛ وذلك أنّ أصحاب الكساء الذي كانوا أكرم الخلق على الله تعالى كانوا خمسة، فلمّا مضى عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقي أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السّلام) فكان فيهم للناس عزاء وسلوة، فلمّا مضت فاطمة (عليها السّلام) كان في أمير المؤمنين والحسن والحسين للناس عزاء وسلوة، فلمّا مضى منهم أمير المؤمنين (عليه السّلام) كان للناس في الحسن والحسين عزاء وسلوة، فلما مضى الحسن (عليه السّلام) كان للناس في الحسين (عليه السّلام) عزاء وسلوة، فلمّا قُتل الحسين (عليه السّلام) لم يكن بقي من أهل الكساء أحد للناس فيه بعده عزاء وسلوة، فكان ذهابه كذهاب جميعهم، كما كان بقاؤه كبقاء جميعهم؛ فلذلك صار يومه أعظم مصيبة».
قال عبد الله بن الفضل الهاشمي: فقلت له: يابن رسول الله، فلِمَ لم يكن للناس في علي بن الحسين عزاء وسلوة، مثل ما كان لهم في آبائه (عليهم السّلام)؟ فقال: «بلى، إنّ علي بن الحسين كان سيّد العابدين، وإماماً وحجّةً على الخلق بعد آبائه
الماضين، ولكنّه لم يلقَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يسمع منه، وكان علمه وراثة عن أبيه عن جدّه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السّلام) قد شاهدهم الناس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحوال في آن يتوالى، فكانوا متى نظروا إلى أحد منهم تذكّروا حاله مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقول رسول الله له وفيه، فلمّا مضوا فقد الناس مشاهدة الأكرمين على الله (عزّ وجلّ)، ولم يكن في أحد منهم فقد جميعهم إلّا في فقد الحسين (عليه السّلام)؛ لأنّه مضى آخرهم، فلذلك صار يومه أعظم الأيام مصيبة»(١) .
ويناسب ذلك ما تقدّم من العقيلة زينب الكبرى (عليها السّلام) في حديثها مع الإمام الحسين (عليه السّلام) ليلة العاشر من قولها: اليوم ماتت أُمّي فاطمة وعلي أبي وحسن أخي. يا خليفة الماضين، وثمال الباقين(٢) .
تذكّر الناس أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره عن عظم الجريمة
الثاني: تذكّر الناس لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين (عليه السّلام) وغيرهما ممّا يتضمّن التنبؤ بالواقعة، وتقييمها، وشدة ألمهما (صلوات الله عليهما وآلهما) وحسرتهما له، وبيان المقام الرفيع الذي يفوز به الإمام الحسين (صلوات الله عليه)، وسوء منقلب الطرف الآخر بسببه، والتأكيد على عظم الجريمة، وتأنيب المسلمين لتقصيرهم إزاءه، وتخاذلهم في أداء واجبهم، وما جرى مجرى ذلك.
تشفّي الأمويين بالفاجعة ثأراً لأسلافهم المشركين
الثالث: ما طفح على لسان الأمويين من التشفّي بقتل الإمام الحسين (صلوات الله عليه) بسبب قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأسلافهم في حروب الإسلام.
____________________
١ - علل الشرائع ١/٢٢٥ - ٢٢٦ ب ١٦٢ العلّة التي من أجلها صار يوم عاشوراء أعظم الأيام مصيبة.
٢ - تقدّمت مصادره في ص: ٥٠.
فعن أبي عبيدة في كتاب المثالب أنّه لما ورد كتاب عبيد الله بن زياد على عمرو بن سعيد الأشدق يبشّره بقتل الحسين (عليه السّلام)، قرأه على الناس، وأومأ إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلاً: يوم بيوم بدر(١) .
وروي مثل ذلك عن يزيد حين أخذ ينكت ثغر الإمام الحسين (عليه السّلام) بالقضيب في مجلسه(٢) ، وكذا عن ابن زياد حين أنكر عليه بعض مَنْ رآه يضرب بالقضيب ثنايا الإمام الحسين (صلوات الله عليه)(٣) .
ولمّا وردت رؤوس القتلى على يزيد - وكان في منظرة له على جيرون - أنشد:
لما بدت تلكَ الحمولُ وأشرقت |
تلكَ الشموسُ على رُبى جيرونِ |
|
نعبَ الغرابُ فقلتُ صح أو لا تصح |
فلقد قضيتُ من الغريمِ ديوني(٤) |
ولما أُدخل عليه رأس الإمام الحسين (صلوات الله عليه) أخذ ينكت ثغره بالقضيب، وأنشد أبيات، منها:
ليتَ أشياخي ببدرٍ شهدوا |
جزعَ الخزرجِ من وقعِ الأسل |
|
لأهلّوا واستهلّوا فرحا |
ثمّ قالوا يا يزيدَ لا تُشل |
|
قد قتلنا القرمَ من ساداتهم |
وعدلناهُ ببدرٍ فاعتدل |
____________________
١ - شرح نهج البلاغة ٤/٧٢، الكامل للمبرد ١/٤٠١، النصائح الكافية/٧٥.
٢ - مناقب آل أبي طالب - لابن شهرآشوب ٣/٢٦٠.
٣ - الأمالي - للصدوق/٢٢٩ المجلس الحادي والثلاثون، روضة الواعظين/١٩٠، بحار الأنوار ٤٥/١٥٤.
٤ - تذكرة الخواص/٢٦١ - ٢٦٢، ورواها الآلوسي هكذا: ولقد اقتضيت من الرسول ديوني، روح المعاني ٢٦/٧٢، ونقل مثله ابن الدمشقي عن تاريخ ابن القفطي كما في جواهر المطالب - لابن الدمشقي ٢/٣٠١، وذكره أيضاً في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ١/١٢٤ مطلب في حرمة اللعن لمعين وما ورد فيه.
لعبت هاشمُ بالملكِ فلا |
خبرٌ جاءَ ولا وحي نزل |
|
لستُ من خندفَ إن لم أنتقم |
من بني أحمدَ ما كان فعل(١) |
وقد استنكرت عليه العقيلة زينب الكبرى (عليها السّلام) ذلك، فخطبت في مجلسه خطبتها الشهيرة، وأشارت لإنشاده الأبيات المذكورة، وقد بدأتها بقولها: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسّلام على سيّد المرسلين، صدق الله تعالى إذ يقول:( ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا السُّوأَى أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِؤُون ) ... أتهتف بأشياخك؟! زعمت تناديهم، فلتردنَّ وشيكاً موردهم، ولتودّنَّ أنّك شُللت وبُكمت ولم تكن قُلت ما قُلت... فكد كيدك، واسعَ سعيك، وناصب جهدك؛ فوالله لا تمحو ذكرنا، ولا تُميت وحينا...(٢) .
الجو الديني الذي عاشه الإمام الحسين (عليه السّلام) وأصحابه
وفي مقابل ذلك كلّه كان الإمام الحسين (صلوات الله عليه) ومَنْ معه يذكّرون بالله (عزّ وجلّ) ويدعون إليه، ويحذّرون من عذابه وانتقامه، ويلهجون بذكره واللجأ إليه والتوكّل عليه، ويردّدون الرضى بما يختاره لهم، ويحتسبون مصائبهم في سبيله تعالى، ويؤكّدون أنّ هدفهم إحقاق الحقّ وإبطال الباطل، وأنّ همّهم رضى الله سبحانه، وأداء حقّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهل بيته، ونحو ذلك، مع
____________________
١ - اللهوف في قتلى الطفوف/١٠٥، واللفظ له، الفتوح - لابن أعثم ٥/١٥٠ - ١٥١ ذكر كتاب عبيد الله بن زياد إلى يزيد بن معاوية وبعثته إليه برأس الحسين بن علي (رضي الله عنهم)، بلاغات النساء/٢١ كلام زينب بنت علي (عليهم السّلام)، مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٦٦ - ٦٧، تذكرة الخواص/٢٦١ ذكر حمل الرأس إلى يزيد، ينابيع المودّة ٣/٣٢، النصائح الكافية/٢٦٣، وذكر بعضه في البداية والنهاية ٨/٢٠٩ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، صفة مقتله مأخوذة من كلام أئمّة الشأن، ومقاتل الطالبيين/٨٠ مقتل الحسين بن علي (عليه السّلام)، وغيرها من المصادر.
٢ - راجع ملحق رقم ٤.
ما ظهر من استجابة دعائهم على أعدائهم في المعركة(١) وبعدها(٢) .
وقد زاد ذلك في البُعد الديني لنهضة الإمام الحسين (عليه السّلام)، فهو الممثّل الحقيقي للدين الحنيف، والداعي إليه، ولم ينهض في وجه مسلمين مؤمنين من أجل الصراع على السلطة كما قد يزعمون، ولا لمجرّد انحرافهم عمليّاً عن تعاليم الإسلام كما قد يظهر بدواً.
وإنّما نهض في وجه منافقين، يبطنون الكفر، ويظهرون الإسلام من أجل الوصول للحكم، والحفاظ عليه؛ فلا يُؤمَن منهم دفع المجتمع الإسلامي نحو الكفر والتخلّي عن الإسلام تدريجياً لو تيسّر لهم ذلك.
وذلك في الحقيقة كان معروفاً للخاصة من مواقف أهل البيت (صلوات الله عليهم) وسلوكهم، ومن منهج معاوية والأمويين عامة، ومن سلوكهم وتعاملهم مع مفردات الإسلام ورموزه، إلّا أنّ مثل هذه التصريحات تزيد ذلك وضوحاً وجلاءً، وتُعطي للنهضة المباركة ولجريمة الأمويين بُعداً عقائدياً يزيد في نقمة المسلمين عموماً عليهم، ويسدّ باب الاعتذار عنهم.
____________________
١ - المصنف - لابن أبي شيبة ٨/٦٣٣ كتاب المغازي، من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنه، مجمع الزوائد ٩/١٩٣ كتاب المناقب، باب مناقب الحسين بن علي (عليهم السّلام)، المعجم الكبير ٣/١١٤، ١١٧ مسند الحسين بن علي، ذكر مولده وصفته، إكمال الكمال ٢/٥٧١ في باب حويزة، تاريخ الطبري ٤/٣٢٨ - ٣٢٩ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، الكامل في التاريخ ٤/٦٦ - ٦٧ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، تاريخ دمشق ١٤/٢٣٣، ٢٣٥ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، الفتوح - لابن أعثم ٥/١٠٨ ذكر اجتماع العسكر إلى حرب الحسين بن علي (رضي الله عنه)، وص ١٣٠ تسمية مَنْ قُتل بين يدي الحسين من ولده وإخوانه وبني عمّه (رضي الله عنهم)، مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٢٤٩، بحار الأنوار ٤٥/٣٠١، وغيرها من المصادر الكثيرة.
٢ - سير أعلام النبلاء ٣/٣١١ في ترجمة الحسين الشهيد، تهذيب الكمال ٦/٤٣٠ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، تاريخ الطبري ٤/٣١٢ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، الكامل في التاريخ ٤/٥٣ - ٥٤ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٣٥، وغيرها من المصادر.
الرابع: انتهاك الأمويين لشهر المحرّم الذي هو من الأشهر الحرم التي حرّم فيها البدء بالقتال في الجاهلية، فضلاً عن الإسلام؛ ولذا أمهل أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في صفين معاوية وأصحابه ولم يقاتلهم حتى خرج شهر المحرّم حفظاً لحرمته(١) .
وفي معتبر الريان بن شبيب قال: دخلت على الرضا (عليه السّلام) في أوّل يوم من المحرّم فقال لي: «أصائم أنت؟». فقلت: لا... ثمّ قال: «يابن شبيب، إنّ المحرّم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية فيما مضى يحرّمون فيه الظلم والقتال لحرمته، فما عرفت هذه الأُمّة حرمة شهرها، ولا حرمة نبيّها صلى الله عليه وآله وسلم؛ لقد قتلوا في هذا الشهر ذريّته، وسبوا نساءه، وانتهبوا ثقله، فلا غفر الله لهم ذلك أبداً. يابن شبيب، إن كنت باكياً لشيء فابكِ للحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السّلام)؛ فإنّه ذُبح كما يُذبح الكبش، وقُتل معه من أهل بيته ثمانية عشر رجلاً ما لهم في الأرض شبيه، ولقد بكت السماوات السبع والأرضون لقتله...»(٢) .
الأحداث الكاشفة عن ارتباط الفاجعة بالله تعالى
الخامس: ما استفاضت به الأخبار التي رواها شيعة أهل البيت والجمهور من حدوث الأمور الغريبة الخارقة للعادة بسبب مصيبة الإمام الحسين (عليه السّلام) الكاشفة عن رفعة شأنه، وعن غضب الله تعالى لفاجعته.
____________________
١ - وقعة صفين/٢٠٢، الفتوح - لابن أعثم ٣/٢١ ذكر الوقعة الثانية بصفين، شرح نهج البلاغة ٤/٢٥ من أخبار يوم صفين، الأخبار الطوال/١٧١ وقعة صفين، بحار الأنوار ٣٢/٤٥٧.
٢ - الأمالي - للصدوق/١٩٢ المجلس السابع والعشرون، حديث الرضا (عليه السّلام) عن يوم عاشوراء، عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) ٢/٢٦٨، بحار الأنوار ٤٤/٢٨٦، إقبال الأعمال ٣/٢٩ فيما نذكره من عمل أوّل ليلة المحرّم.
فقد رمى الإمام الحسين (عليه السّلام) بشيء من دمه(١) ودم ولده(٢) للسماء فلم يسقط منه قطرة(٣) .
ولما صُرع علي بن الحسين الأكبر (عليه السّلام) نادى رافعاً صوته: هذا جدّي رسول الله قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبداً، وهو يقول: العجل، فإنّ لك كأساً مذخورة(٤) .
وتكلّم رأس الإمام الحسين (صلوات الله عليه) بعد قتله(٥) ، وظهرت الأنوار محيطة به(٦) .
____________________
١ - تاريخ الطبري ٤/٣٤٣ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، الكامل في التاريخ ٤/٧٦ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، تاريخ دمشق ١٤/٢٢٣ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، تهذيب الكمال ٦/٤٣٠ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، سير أعلام النبلاء ٣/٣١١ في ترجمة الحسين الشهيد، الوافي بالوفيات ١٢/٢٦٥ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، مناقب آل أبي طالب - لابن شهرآشوب ٣/٢١٤، ذخائر العقبى/١٤٤، بحار الأنوار ٤٥/٣٠١ - ٣١١، وغيرها من المصادر.
٢ - مقاتل الطالبيين/٥٩ - ٦٠ عبد الله بن الحسين بن علي بن أبي طالب، اللهوف في قتلى الطفوف/٦٩، مناقب آل أبي طالب - لابن شهرآشوب ٣/٢٥٧، مثير الأحزان/٥٣ - ٥٤، بحار الأنوار ٤٥/٤٦، وغيرها من المصادر.
٣ - تاريخ دمشق ١٤/٢٢٣ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٣٤، كفاية الطالب/٤٣٢، بحار الأنوار ٤٥/٥٣، وغيرها من المصادر.
٤ - مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٣١، واللفظ له، مقاتل الطالبيين/٧٧ مقتل الحسين بن علي (عليهما السّلام)، اللهوف في قتلى الطفوف/٦٧، بحار الأنوار ٤٥/٤٤، وغيرها من المصادر.
٥ - تاريخ دمشق ٢٢/١١٧ - ١١٨ في ترجمة سلمة بن كهيل، و٦٠/٣٧٠ في ترجمة منهال بن عمرو، الوافي بالوفيات ١٥/٢٠٠ في ذكر سلمة بن كهيل الحضرمي، فيض القدير ١/٢٦٥، الإرشاد ٢/١١٧، إعلام الورى بأعلام الهدى ١/٤٧٣، الخرائج والجرائح ٢/٥٧٧، وغيرها من المصادر.
٦ - الكامل في التاريخ ٤/٨٠ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، تاريخ الطبري ٤/٣٤٨ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، مناقب آل أبي طالب - لابن شهرآشوب ٣/٢١٧، ينابيع المودّة ٣/٩٠، وغيرها من المصادر.
وصار التراب الذي دفعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأُمّ سلمة من تربته دماً علامة على قتله(١) .
وانكسفت الشمس حتى بدت الكواكب نصف النهار(٢) ، وأخذ بعضها يضرب بعضاً(٣) ، وأظلمت الدنيا ثلاثة أيام(٤) ، واسودّت(٥) ،
____________________
١ - الكامل في التاريخ ٤/٩٣ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٩٥ - ٩٧ الفصل الثاني عشر، تاريخ اليعقوبي ٢/٢٤٥ مقتل الحسين بن علي، معارج الوصول/٩٤ إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يجري على الحسين (عليه السّلام)، نظم درر السمطين، ٢١٧، ينابيع المودّة ٣/١٢، الأمالي - للطوسي/٣١٥، مناقب آل أبي طالب - لابن شهرآشوب ٣/٢١٣ باب إمامة أبي عبد الله الحسين، وغيرها من المصادر.
٢ - السنن الكبرى - للبيهقي ٣/٣٣٧ كتاب صلاة الخسوف، باب ما يستدل به على جواز اجتماع الخسوف والعيد لجواز وقوع الخسوف في العاشر من الشهر، مجمع الزوائد ٩/١٩٧ كتاب المناقب، باب مناقب الحسين بن علي (عليهما السّلام)، المعجم الكبير ٣/١١٤ ح ٢٨٣٨ مسند الحسين بن علي، ذكر مولده وصفته وهيأته، فيض القدير ١/٢٦٥، تاريخ دمشق ١٤/٢٢٨ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، تهذيب الكمال ٦/٤٣٣ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، أنساب الأشراف ٣/٤١٣ مقتل الحسين بن علي (عليهما السّلام)، وغيرها من المصادر الكثيرة.
٣ - مجمع الزوائد ٩/١٩٧ كتاب المناقب، باب مناقب الحسين بن علي (عليهما السّلام)، المعجم الكبير ٣/١١٤ ح ٢٨٣٩ مسند الحسين بن علي، ذكر مولده وصفته وهيأته، تاريخ دمشق ١٤/٢٢٧ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، تهذيب الكمال ٦/٤٣٣ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، سير أعلام النبلاء ٣/٣١٢ في ترجمة الحسين الشهيد، تاريخ الإسلام ٥/١٥ الطبقة السابعة، حوادث سنة واحد وستين، مقتل الحسين، وغيرها من المصادر.
٤ - تاريخ دمشق ١٤/٢٢٩ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، تهذيب الكمال ٦/٤٣٤ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، نظم درر السمطين/٢٢١، معارج الوصول/٩٩، إمتاع الأسماع - للمقريزي ١٢/٢٤٣، و١٤/١٥٠، بغية الطلب في تاريخ حلب ٦/٢٦٣٧، مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٩١ الفصل الثاني عشر، الصواعق المحرقة/٢٩٥ الفصل الثالث في الأحاديث الواردة في بعض أهل البيت كفاطمة وولديه، بحار الأنوار ٤٥/٢١٦، وغيرها من المصادر.
٥ - تاريخ دمشق ١٤/٢٢٦ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، تهذيب الكمال ٦/٤٣٢ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، تهذيب التهذيب ٢/٣٠٥ في ترجمة الحسين بن علي بن =
حتى ظنّوا أنّها القيامة(١) ، ومطرت السماء دماً(٢) كما تعرّضت له العقيلة زينب في خطبتها في الكوفة(٣) ، ولم يُرفع حجر في بيت المقدس(٤)
____________________
= أبي طالب، الوافي بالوفيات ١٢/٢٦٥، ينابيع المودّة ٣/١٥، الصواعق المحرقة/٢٩٤ الفصل الثالث في الأحاديث الواردة في بعض أهل البيت كفاطمة وولديها، وغيرها من المصادر.
١ - السنن الكبرى - للبيهقي ٣/٣٣٧ كتاب صلاة الخسوف، باب ما يستدلّ به على جواز اجتماع الخسوف والعيد لجواز وقوع الخسوف في العاشر من الشهر، مجمع الزوائد ٩/١٩٧ كتاب المناقب، باب مناقب الحسين بن علي (عليهما السّلام)، المعجم الكبير ٣/١١٤ ح ٢٨٣٨ مسند الحسين بن علي، ذكر مولده وصفته وهيأته، تاريخ دمشق ١٤/٢٢٨ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، تهذيب الكمال ٦/٤٣٣ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، الدرّ النظيم/٥٦٧، الصواعق المحرقة/٢٩٥ الفصل الثالث في الأحاديث الواردة في بعض أهل البيت كفاطمة وولديها، نظم درر السمطين/٢٢٠، وغيرها من المصادر.
٢ - الثقات - لابن حبان ٥/٤٨٧ في ترجمة نضرة الأزدية، سير أعلام النبلاء ٣/٣١٢ في ترجمة الحسين الشهيد، العمدة - لابن بطريق/٤٠٦ ح ٨٣٨ فصل في مناقب الحسن والحسين (عليهما السّلام)، تفسير الثعلبي ٨/٣٥٣، تفسير القرطبي ١٦/١٤١، تاريخ دمشق ١٤/٢٢٧، ٢٢٩ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، تهذيب الكمال ٦/٤٣٣ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، الجرح والتعديل ٤/٢١٦، ترجمة الإمام الحسين (عليه السّلام) من طبقات ابن سعد/٩٠ ح ٣٢١، ذخائر العقبى/١٤٥ ذكر الحسن والحسين، كرامات وآيات ظهرت لمقتله، نظم درر السمطين/٢٢٢، إمتاع الأسماع ١٢/٢٤١، و١٤/١٤٩، وغيرها من المصادر الكثيرة جدّاً.
وعن جعفر بن سليمان قال: حدّثتني خالتي أُمّ سالم قالت: لما قُتل الحسين بن علي مُطرنا مطراً كالدم على البيوت والجدر. قال: وبلغني أنّه كان بخراسان والشام والكوفة، تاريخ دمشق ١٤/٢٢٩ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، تهذيب الكمال ٦/٤٣٣ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، بغية الطلب في تاريخ حلب ٦/٢٦٣٨، الصواعق المحرقة/٢٩٥ الفصل الثالث في الأحاديث الواردة في بعض أهل البيت كفاطمة وولديها.
٣ - راجع ملحق رقم ٣.
٤ - مجمع الزوائد ٩/١٩٦ كتاب المناقب، باب مناقب الحسين بن علي (عليهما السّلام)، المعجم الكبير ٣/١١٣ ح ٢٨٣٤ مسند الحسين بن علي، ذكر مولده وصفته وهيأته، تاريخ دمشق ١٤/٢٢٩ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، تهذيب الكمال ٦/٤٣٤ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، سير أعلام النبلاء ٣/٣١٤ في ترجمة الحسين الشهيد، تهذيب التهذيب ٢/٣٠٥ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، تاريخ الإسلام ٥/١٦ الطبقة السابعة، حوادث سنة واحد =
وغيره(١) إلّا وجد تحته دم عبيط، ولما وضِعَ الرأس المقدّس أمام ابن زياد في قصر الإمارة سالت حيطان القصر دماً(٢) .
ونبع الدم من ساق شجرة أُمّ معبد التي أورقت وأثمرت ببركة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طريق مهاجره من مكة إلى المدينة(٣) .
____________________
= وستين، مقتل الحسين، إمتاع الأسماع ١٤/١٤٩ - ١٥١، وغيرها من المصادر الكثيرة.
١ - مجمع الزوائد ٩/١٩٦ كتاب المناقب، باب مناقب الحسين بن علي (عليهما السّلام)، المعجم الكبير ٣/١١٣ ح ٢٨٣٥ مسند الحسين بن علي، ذكر مولده وصفته وهيأته، تاريخ دمشق ١٤/٢٢٦ - ٢٣٠ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، تاريخ الإسلام ٥/١٦ الطبقة السابعة، حوادث سنة واحد وستين، مقتل الحسين، أنساب الأشراف ٣/٤٢٥ مقتل الحسين بن علي (عليهما السّلام)، الوافي بالوفيات ١٢/٢٦٥، ترجمة الإمام الحسين (عليه السّلام) من طبقات ابن سعد/٩٠ - ٩١ ح ٣٢٣، ٣٢٥، نظم درر السمطين/٢٢٠، إمتاع الأسماع ١٢/٢٤٢، و١٩/١٥٠، وغيرها من المصادر الكثيرة.
٢ - تاريخ دمشق ١٤/٢٢٩ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، تهذيب الكمال ٦/٤٣٤ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، ذخائر العقبى/١٤٥ ذكر الحسن والحسين، كرامات وآيات ظهرت لمقتله، سبل الهدى والرشاد ١١/٨٠ الباب الثاني عشر، بغية الطلب في تاريخ حلب ٦/٢٦٣٦، الصواعق المحرقة/٢٩٥ الفصل الثالث في الأحاديث الواردة في بعض أهل البيت كفاطمة وولديها، وغيرها من المصادر.
٣ - روى الخوارزمي بسنده عن هند بنت الجون، قالت: نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخيمة خالتي... فلمّا قام من رقدته دعا بماء فغسل يديه فأنقاهم، ثمّ مضمض فاه ومجّه على عوسجة كانت إلى جنب خيمة خالتي ثلاث مرّات... ثمّ قال: «إنّ لهذه العوسجة شأن...». فلمّا كان من الغد أصبحنا وقد علت العوسجة حتى صارت كأعظم دوحة عالية وأبهى، وقد خضد الله شوكها، ووشجت عروقها، وكثرت أفنانها، واخضر ساقها وورقها، ثمّ أثمرت بعد ذلك... فلم نزل كذلك وعلى ذلك حتى أصبحنا ذات يوم وقد تساقط ثمارها، واصفرّ ورقها، فأحزننا ذلك وفزعنا من ذلك، فما كان إلّا قليلاً حتى جاء نعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هو قد قُبض ذلك اليوم، فكانت بعد ذلك تثمر ثمراً دون ذلك في العِظم والطعم والرائحة، فأقامت على ذلك نحو ثلاثين سنة، فلمّا كان ذات يوم أصبحنا =
وظهرت الحمرة في السماء(١) ، ومكث الناس شهرين أو ثلاثة كأنّما تلطّخ
____________________
= وإذا بها قد شاكت من أوّلها إلى آخره، وذهبت نضارة عيدانها، وتساقطت جميع ثمرتها، فما كان إلّا يسيراً حتى وافى خبر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السّلام)، فما أثمرت بعد ذلك لا قليلاً ولا كثيراً، وانقطع ثمرها، ولم نزل نحن ومَنْ حولنا نأخذ من ورقها ونداوي به مرضانا، ونستشفي به من أسقامنا، فأقامت على ذلك برهة طويلة، ثمّ أصبحنا ذات يوم فإذا بها قد انبعث من ساقها دم عبيط، وإذا بأوراقها ذابلة تقطر دماً كماء اللحم. فقلنا: قد حدثت حادثة عظيمة. فبتنا ليلتنا فزعين مهمومين نتوقّع الحادثة، فلمّا اظلم الليل علينا سمعنا بكاءً وعويلاً من تحت الأرض، وجَلَبة شديدة ورجّة، وسمعنا صوت نائح يقول:
أيابن النبي ويابن الوصي |
بقيّة ساداتنا الأكرمين |
وكثر الرنين والأصوات فلم نفهم كثيراً ممّا كانوا يقولون، فأتانا بعد ذلك خبر قتل الحسين (عليه السّلام) ويبست الشجرة، وجفّت وكسّرتها الأرياح والأمطار، فذهبت ودرس أثرها.
قال عبد الله بن محمد الأنصاري: فلقيت دعبل بن علي الخزاعي في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فحدّثته بهذا الحديث فلم ينكره، وقال: حدّثني أبي، عن جدّي، عن أُمّه سعدى بنت مالك الخزاعية أنّها أدركت تلك الشجرة، وأكلت من ثمرها على عهد علي بن أبي طالب (عليه السّلام)، وأنّها سمعت ليلة قتل الحسين (عليه السّلام) نوح الجن...
مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٩٨ - ١٠٠ الفصل الثاني عشر، في عقوبة قاتل الحسين (عليه السّلام)، ورواه بسنده أيضاً ابن العديم في بغية الطلب في تاريخ حلب ٦/٢٦٤٨ - ٢٦٥٠، وراجع أيضاً ربيع الأبرار ١/٢٨٥ - ٢٨٦ باب الشجر والنبات والفواكه والرياحين والبساتين والرياض وذكر الجنة، والتذكرة الحمدونية ٣/١١٦ فنون الشعر وغرائبه، وتاريخ الخميس ١/٣٣٤ - ٣٣٥ قصّة أُمّ معبد، والثاقب في المناقب/١١٢، ومناقب آل أبي طالب - لابن شهرآشوب ١/١٠٦، وكشف الغمة ١/٢٥، والدر النظيم/١٣١، وبحار الأنوار ١٨/٤١، وغيرها من المصادر.
١ - تاريخ دمشق ١٤/٢٢٦ - ٢٢٨ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، تهذيب الكمال ٦/٤٣٢ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، جزء الحميري/٣١، أنساب الأشراف ٣/٤١٣ مقتل الحسين بن علي (عليهما السّلام)، ترجمة الإمام الحسين من طبقات ابن سعد/٩١ ح ٣٢٥ - ٣٢٧، نظم درر السمطين/٢٢١، معارج الوصول/٩٨، ينابيع المودة ٣/٢٠، وغيرها من المصادر.
الحوائط بالدماء ساعة تطلع الشمس حتى ترتفع(١) .
واضطرمت في وجه ابن زياد النار عند قتل الحسين (عليه السّلام)، فنحاها بكمّه، وأمر حاجبه بكتمان ذلك(٢) ... إلى غير ذلك(٣) .
الرؤى المؤكّدة لعظم الجريمة
ومثل ذلك بعض الرؤى المتعلّقة بالفاجعة، كرؤيا ابن عباس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيده قارورة يجمع فيها دماء الإمام الحسين (صلوات الله عليه) وأصحابه (عليهم السّلام)؛ ليرفعها إلى الله تعالى(٤) ، ورؤيا أُمّ سلمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً مغبراً، وقال لها:
____________________
١ - تاريخ الطبري ٤/٢٩٦ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مسير الحسين (عليه السّلام) من مكة متوجّهاً إلى الكوفة وما كان من أمره في مسيره، الكامل في التاريخ ٤/٩٠ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، البداية والنهاية ٨/١٨٥ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، وغيرها من المصادر.
٢ - مجمع الزوائد ٩/١٩٦ كتاب المناقب، باب مناقب الحسين بن علي (عليهما السّلام)، المعجم الكبير ٣/١١٢ ح ٢٨٣١ مسند الحسين بن علي، ذكر مولده وصفته وهيأته، تاريخ دمشق ٣٧/٤٥١ في ترجمة عبيد الله بن زياد بين عبيد، الكامل في التاريخ ٤/٢٦٥ أحداث سنة سبع وستين من الهجرة، ذكر مقتل ابن زياد، البداية والنهاية ٨/٣١٤ أحداث سنة سبع وستين من الهجرة، ترجمة ابن زياد، وغيرها من المصادر.
٣ - تاريخ الطبري ٤/٢٩٦ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مسير الحسين (عليه السّلام) من مكة متوجّهاً إلى الكوفة وما كان من أمره في مسيره، الكامل في التاريخ ٤/٩٠ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، البداية والنهاية ٨/١٨٥ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، صفة مقتله مأخوذة من كلام أئمّة الشأن، أنساب الأشراف ٣/٤١٣ - ٤٢٤ مقتل الحسين بن علي (عليهما السّلام)، بغية الطلب ٦/٢٦٣٩، وغيرها من المصادر.
٤ - تاريخ دمشق ١٤/٢٣٧ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، البداية والنهاية ٨/٢١٨ في أحداث سنة إحدى وستين، فصل بلا عنوان بعد ذكر صفة مقتله، الكامل في التاريخ ٤/٩٣ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه).
وذكر ذلك أيضاً من غير النصّ على الرفع إلى الله تعالى في مسند أحمد ١/٢٤٢، ٢٨٣ مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومستدرك الصحيحين ٤/٣٩٨ كتاب تعبير =
«شهدت قتل الحسين آنفاً»(١) ، وغيرهما ممّا ذكره المؤرّخون(٢) .
وفي بعضها أنّ صاحب الرؤيا ممّن شارك في الجيش الذي حارب الإمام الحسين (عليه السّلام) فعوقب في الرؤيا بما لقي أثره بعد أن أفاق، أو رأى تصديقها بعد ذلك(٣) .
____________________
= الرؤيا، ومجمع الزوائد ٩/١٩٤ كتاب المناقب، باب مناقب الحسين بن علي (عليهما السّلام)، والمعجم الكبير ٣/١١٠ ح ٢٨٢٢ مسند الحسين بن علي، ذكر مولده وصفته وهيأته، و١٢/١٤٣ ما رواه عمار بن أبي عمار عن ابن عباس، ومسند عبد بن حميد/٢٣٥ مسند ابن عباس، والاستيعاب ١/٣٩٥ - ٣٩٦ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، وتاريخ بغداد ١/١٥٢ في ترجمة الحسن والحسين، وغيرها من المصادر الكثيرة.
١ - مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٩٦ الفصل الثاني عشر، واللفظ له، سنن الترمذي ٥/٣٢٣ ح ٣٨٦٠ أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مناقب أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب والحسين بن علي بن أبي طالب (رضي الله عنهم)، المستدرك على الصحيحين ٤/١٩ تسمية أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر أُمّ سلمة بنت أبي أُميّة (رضي الله عنهم)، المعجم الكبير ٢٣/٣٧٣ ما أسندت أُمّ سلمة، ما روته سلمى عن أُمّ سلمة، التاريخ الكبير ٣/٣٢٤ عند ذكر رزين بياع الأنماط، تاريخ دمشق ١٤/٣٢٨ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، أسد الغابة ٢/٢٢ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، تهذيب الكمال ٦/٤٣٩ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، و٩/١٨٧ في ترجمة رزين بن سليمان الأحمري، سير أعلام النبلاء ٣/٣١٦ في ترجمة الحسين الشهيد، وغيرها من المصادر الكثيرة.
٢ - تاريخ دمشق ١٤/٢٥٨ - ٢٥٩ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، تهذيب الكمال ٦/٤٤٦ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب.
٣ - روى ابن عساكر عن أبي النضر الجرمي أنّه قال: رأيت رجلاً سمج العمى، فسألته عن سبب ذهاب بصره، فقال: كنت ممّن حضر عسكر عمر بن سعد، فلمّا جاء الليل رقدت، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام بين يديه طست فيها دم وريشة في الدم، وهو يؤتى بأصحاب عمر بن سعد فيأخذ الريشة فيخطّ بها بين أعينهم، فأتي بي فقلت: يا رسول الله، والله ما ضربت بسيف، ولا طعنت برمح، ولا رميت بسهم. قال: «أفلم تكثر عدوّنا؟». فأدخل إصبعه في الدم، السبابة والوسطى، وأهوى بهما إلى عيني فأصبحت وقد ذهب بصري. تاريخ دمشق ١٤/٢٥٩ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، وروي قريباً من ذلك عن ابن رباح في مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/١٠٤ الفصل الثاني عشر في بيان عقوبة قاتل =
نوح الجنّ على الإمام الحسين (عليه السّلام)
وكذا ما استفاض من سماع الناس نوح الجنّ على الإمام الحسين (صلوات الله عليه)(١) ، وظهور قلم يكتب على الحائط:
أترجو أُمّة قتلت حسينا |
شفاعة جدّه يوم الحساب(٢) |
كما إنّه قد وجد هذا الشعر في عدّة أماكن ذكر أهلها أنّه قد كُتب فيها من مدّة طويلة قبل ظهور الإسلام(٣) .
____________________
= الحسين (عليه السّلام) وخاذله وما له من الجزاء، كما روي آخر المقتل المذكور ٢/٨٧ - ١٠٤، وتاريخ دمشق ١٤/٢٥٨ - ٢٥٩ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، واللهوف في قتلى الطفوف/٨٠، ١٠٠ - ١٠١، ومقاتل الطالبيين/٧٩، وبحار الأنوار ٤٥/٣٠٦، ٣٠٨، ٣١١، ٣١٦ - ٣٢١، وغيرها من المصادر.
١ - مجمع الزوائد ٩/١٩٩ كتاب المناقب، باب مناقب الحسين بن علي (عليهما السّلام)، المعجم الكبير ٣/١٢١ - ١٢٢ ح ٢٨٦٢، ٢٨٦٤ - ٢٨٦٩ مسند الحسين بن علي، ذكر مولده وصفته وهيأته، الإصابة ٢/٧٢ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، الآحاد والمثاني ١/٣٠٨، تاريخ دمشق ١٤/٢٣٩ - ٢٤٢ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، تهذيب الكمال ٦/٤٤١ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، تهذيب التهذيب ٢/٣٠٦ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، البداية والنهاية ٦/٢٥٩ الإخبار بمقتل الحسين بن علي (رضي الله عنهم)، و٨/٢١٩ في أحداث سنة إحدى وستين، فصل بلا عنوان بعد ذكر صفة مقتله، سير أعلام النبلاء ٣/٣١٦ - ٣١٧ في ترجمة الحسين الشهيد، كتاب الهواتف/٨٧ باب هواتف الجنّ، وغيرها من المصادر الكثيرة.
٢ - مجمع الزوائد ٩/١٩٩ كتاب المناقب، باب مناقب الحسين بن علي (عليهما السّلام)، المعجم الكبير ٣/١٢٣ ح ٢٨٧٣ مسند الحسين بن علي، ذكر مولده وصفته وهيأته، تاريخ دمشق ١٤/٢٤٤ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، تهذيب الكمال ٦/٤٤٣ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، تاريخ الإسلام ٥/١٠٧ في ترجمة الحسين بن علي (رضي الله عنه)، البداية والنهاية ٨/٢١٨ في أحداث سنة إحدى وستين، فصل بلا عنوان بعد ذكر صفة مقتله، ذيل تاريخ بغداد ٤/١٥٩ في ترجمة علي بن نصر، وغيرها من المصادر.
٣ - تقدّمت مصادره في/٤٣.
التنكيل الإلهي بقتلته (عليه السّلام) وما حصل فيما سلب منه
ومن ذلك ما استفاض في أخبار الفريقين من انتقام الله (عزّ وجلّ) من قتلة الإمام الحسين (عليه السّلام) في الدنيا قبل الآخرة، وما حصل فيما سلب منه (عليه السّلام) ومن رحله - من الإبل والورس وغيرها - بحيث أوجب تعذّر الانتفاع بها، أو حصول النكال بسببه... إلى غير ذلك ممّا ذكره المؤرّخون، ولا نطيل باستقصاء مفرداته.
فإنّ هذه الأمور بمجموعها زادت في وقع المصيبة على المسلمين، وكشفت عن عظم الجريمة عند الله (عزّ وجلّ) حتى عجّل بإظهار سخطه في الدنيا؛ ليلفت نظر الناس لذلك، ويقيم الحجّة عليهم.
الإمام الحسين (عليه السّلام) ثار الله تعالى وابن ثاره
ومن جميع ذلك يظهر الوجه في استحقاق الإمام الحسين (صلوات الله عليه) أن يكون ثار الله تعالى في الأرض، كما تضمّنت الزيارات الواردة عن أئمّة أهل البيت (صلوات الله عليهم) ذلك في حقّه وحق أبيه أمير المؤمنين (عليهما وعلى آلهما أفضل الصلاة والسّلام).
ففي صحيح الحسين بن ثوير عن الإمام الصادق (عليه السّلام) الوارد في زيارة الإمام الحسين (عليه السّلام) التي فيها قوله (عليه السّلام): «السّلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله. السّلام عليك يا ثار الله وابن ثاره. السّلام عليك يا وتر الله الموتور في السماوات والأرض...، وأشهد أنّك ثار الله في الأرض وابن ثاره»(١) ، ونحوها غيرها(٢) .
وهو المناسب لما في حديث جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول:
____________________
١ - كامل الزيارات/٣٦٤ - ٣٦٥، تهذيب الأحكام ٦/٥٥.
٢ - كامل الزيارات/٣٥٨، ٣٨٦، ٣٨٩، ٤٠٦، مصباح الزائر/٢٩٢، وغيره.
«يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون إلى الله (عزّ وجلّ): المصحف والمسجد والعترة. يقول المصحف: يا ربّ حرقوني ومزّقوني. ويقول المسجد: يا ربّ عطّلوني وضيّعوني. وتقول العترة: يا ربّ قتلونا وطردونا وشرّدونا؛ فأجثوا الركبتين للخصومة، فيقول الله (جلّ جلاله) لي: أنا أولى بذلك»(١) .
كما يناسبه أيضاً ما سبق من أنّ الإمام الحسين (صلوات الله عليه) رمى بدمه الزكي ودم ولده إلى السماء فلم ينزل منه قطرة(٢) ، وفي بعض المصادر أنّه (عليه السّلام) خاطب الله (عزّ وجلّ) قائلاً: «اللّهمّ اطلب بدم ابن بنت نبيّك»(٣) .
وكذا قوله (عليه السّلام) لما ذُبح ولده الرضيع: «والله، لأنت أكرم على الله من الناقة، ولمحمد أكرم على الله من صالح»(٤) .
وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.
____________________
١ - الخصال/١٧٥، واللفظ له، كنز العمّال ١١/١٩٣ ح ٣١١٩٠، بحار الأنوار ٢٤/١٨٦ - ١٨٧، و٨٠/٣٦٨.
٢ - تقدّمت مصادره في/٨٣.
٣ - تاريخ دمشق ١٤/٢٢٣ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، واللفظ له، الوافي بالوفيات ١٢/٢٦٥ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب (رضي الله عنهم)، كفاية الطالب/٤٣١.
٤ - تقدّمت مصادره في/٧٤ - ٧٥.
الفصل الثاني
في ردود الفعل المباشرة
لفاجعة الطف
والكلام فيه في مقامين:
المقام الأوّل
في رد الفعل من قبل الناس
إنّ الناظر في تاريخ الواقعة وما قارنها يرى أنّ الغشم والعنف، والترهيب والترغيب كانت هي الدافع لتنفيذ هذه الجريمة العظمى، مع كثير من التململ والضيق، والصراع النفسي والتفاعل العاطفي مع الإمام الحسين (صلوات الله عليه) وأهل بيته (عليهم السّلام) حتى من بعض القائمين به؛ لوضوح رفعة مقام أهل البيت (صلوات الله عليهم)، ولحصول كثير من الجرائم البشعة والممارسات الصارخة المثيرة للعاطفة حتى من قبل الأعداء.
حتى إذا انتهت الجريمة وتمّ للسلطة ما أرادت رجع الناس إلى واقعهم، وعرفوا فداحة المصاب، وشدّة الجريمة، وهول ما فعلوا.
فإنّ من المعلوم:
أوّلاً: إنّ السلطة تعاملت مع الإمام الحسين (صلوات الله عليه) على أنّه خارج عن الشرعيّة، وشاقّ للعصا، وملقّح للفتنة، ومستحقّ للقتل والتنكيل.
بل تعاملت مع نهضته المباركة تعاملها مع الردّة سلباً وسبياً وتشهيراً، وبمنتهى الوحشية، بمثل قطع الرؤوس، ورضّ الأجساد، والسبّ والشتم، والشماتة والتشفي، وغير ذلك.
وثانياً: إنّ السلطة كانت في أوج قوّتها وشراستها في التنكيل بمَنْ يخالفها أو يخرج عن مسارها أو يعترض عليها؛ ولذا ردّت في السنة الثالثة على أهل المدينة في واقعة الحرّة أبشع ردّ، وانتهكت حرمتهم أشنع انتهاك، ولم تتورّع في السنة الرابعة عن الردّ على عبد الله بن الزبير بانتهاك حرمة الحرم، وبضرب مكّة المكرّمة والكعبة المعظمة بالمنجنيق.
وكان نصيب الكوفة - التي هي علوية الهوى - من العمّال عبيد الله بن زياد الغليظ القاسي الجبّار الشرس الذي قام بنفسه بتلك الجريمة الكبرى بتبجّح واستهتار، واستطاع أن يُرغم الكوفيين على تنفيذه.
كما كان نصيب المدينة المنوّرة التي - هي موطن أهل البيت (صلوات الله عليهم) - عمرو بن سعيد الأشدق جبّار بني أُميّة(١) ، والشامت بقتل الإمام الحسين (صلوات الله عليه)، كما سبق ويأتي(٢) .
____________________
١ - فقد روي عن أبي هريرة أنّه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «ليرعفن على منبري جبّار من جبابرة بني أُميّة يسيل رعافه». قال: فحدّثني مَنْ رأى عمرو بن سعيد بن العاص رعف على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى سال رعافه. مسند أحمد ٢/٥٢٢ مسند أبي هريرة، واللفظ له، مجمع الزوائد ٥/٢٤٠ كتاب الخلافة، باب في أئمّة الظلم والجور وأئمّة الضلالة، تاريخ الإسلام ٥/٢٠٤ في ترجمة عمرو بن سعيد بن العاص، تاريخ دمشق ٤٦/٣٦٠ في ترجمة عمرو بن سعيد بن العاص، البداية والنهاية ٨/٣٤٢ أحداث سنة تسع وستين من الهجرة في ترجمة الأشدق، بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث/١٩٤ كتاب الإمارة، باب في ولاة السوء، وغيرها من المصادر.
٢ - راجع ص: ٧٩، وص: ١٠٣.
وكان المفروض مع هذين الأمرين أن تُكمّ الأفواه، وتُكتم العواطف إزاء الفاجعة، كما عشنا ذلك مع مآسي العراق الكثيرة وفجائعه الفادحة في العهد الطويل للطغيان والجبروت والدكتاتورية الغاشمة.
بل يفترض أن تقام مظاهر الفرح والزينة بالانتصار الكاسح والفتح العظيم للسلطة في هذين المصرين، كما أُقيمت في الشام المعزولة عن عامّة المسلمين ثقافياً والتي لا تعرف عن أهل البيت (صلوات الله عليهم) إلّا ما عرّفها الأمويون.
إلاّ إنّه يبدو أنّ هول الفاجعة - بأبعادها السابقة - وشدّة وقعها في النفوس أفقد الناس السيطرة على عواطفهم وكبح جماحها، بحيث اضطرت السلطة أن تقف مكتوفة اليد أمام ذلك.
إنكار بعض الصحابة على يزيد وابن زياد
ولا نعني بذلك الإنكارات الشخصية من بعض الصحابة على عبيد الله بن زياد وعلى يزيد حينما أخذا ينكتان رأس الإمام الحسين (عليه السّلام) بالقضيب تشفياً منه، كزيد بن أرقم(١) وأبي برزة الأسلمي(٢) وأنس بن مالك(٣) ؛ إذ ربما كانوا يشعرون ببعض الحصانة لمركزهم الاجتماعي، ولأنّ الدولة كانت تتجمّل بهم، فلا تقدم على قتلهم بعد أن لم يكن لإنكارهم مظهر على الصعيد العام.
بل اقتصرت على الإنكار عليهم أو على بعضهم بشدة، كقول عبيد الله بن زياد لزيد بن أرقم: «أبكى الله عينيك! فو الله لولا أنك شيخ قد خرفت وذهب
____________________
١ - تقدّمت مصادره في/٦٠.
٢ - تقدّمت مصادره في/٦٠.
٣ - تقدّمت مصادره في/٥٩.
عقلك لضربت عنقك»(١) ، وأمر يزيد بإخراج أبي برزة الأسلمي سحباً(٢) .
إنكار يحيى بن الحكم
ولا نعني أيضاً مثل إنكار يحيى بن الحكم، حيث قال حين أُدخل الرأس الشريف إلى مجلس يزيد:
لهامٌ بجنبِ الطفّ أدنى قرابة |
من ابنِ زيادِ العبدِ ذي الحسبِ الوغلِ |
|
سميةَ أمسى نسلها عددَ الحصى |
وليسَ لآلِ المصطفى اليومَ من نسلِ |
ولا قوله لمَنْ جاء بالرؤوس والسبايا للشام: حُجبتم عن محمد يوم
____________________
١ - تاريخ الطبري ج: ٤ ص: ٣٤٩ في أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، واللفظ له. الكامل في التاريخ ج: ٤ ص: ٨١ في أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة: ذكر مقتل الحسين. أسد الغابة ج: ٢ ص: ٢١ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب. الأخبار الطوال ص: ٢٥٩ - ٢٦٠ نهاية الحسين. البداية والنهاية ج: ٨ ص: ٢٠٧ في أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة: صفة مقتله مأخوذة من أئمة الشأن. وغيرها من المصادر الكثيرة.
٢ - الفتوح لابن أعثم ج: ٥ ص: ١٥٠ ذكر كتاب عبيد الله بن زياد إلى يزيد بن معاوية وبعثته إليه برأس الحسين بن علي (عليهما السلام). اللهوف في قتلى الطفوف ص: ١٠٥.
٣ - تاريخ الطبري ٤/٣٥٢ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، واللفظ له، تاريخ دمشق ٦٤/١٢٣ في ترجمة يحيى بن الحكم بن أبي العاص، الكامل في التاريخ ٤/٨٩ - ٩٠ في أحداث سنة إحدى وستين، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، البداية والنهاية ٨/٢٠٨ - ٢٠٩ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، صفة مقتله مأخوذة من كلام أئمّة الشأن، وغيرها من المصادر.
ونسب هذا البيت إلى عبد الرحمن بن أُمّ الحكم في مجمع الزوائد ٩/١٩٨ كتاب المناقب، باب مناقب الحسين بن علي (عليهما السّلام)، والمعجم الكبير ٣/١١٦ ح ٢٨٤٨ مسند الحسين بن علي، ذكر مولده وصفته وهيأته، وتاريخ دمشق ٣٤/٣١٦ في ترجمة عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص، وتاريخ الإسلام ٥/١٨ الطبقة السابعة، حوادث سنة واحد وستين، مقتل الحسين، والوافي بالوفيات ١/٦٢٣، وأنساب الأشراف ٣/٤٢١ مقتل الحسين بن علي (عليهما السّلام)، وغيرها من المصادر.
القيامة، لن أجامعكم على أمر أبداً. ثمّ قام فانصرف(١) .
فإنّه أيضاً كان يتمتّع بحصانة النسب الأموي، ولم يكن لإنكاره مظهر على الصعيد العام.
إنكار ابن عفيف الأزدي على ابن زياد في مسجد الكوفة
كما لا نعني إنكار عبد الله بن عفيف الأزدي على ابن زياد حينما جمع الناس في مسجد الكوفة، وخطبهم فقال: الحمد لله الذي أظهر الحقّ وأهله، ونصر أمير المؤمنين يزيد وحزبه، وقتل الكذّاب بن الكذّاب الحسين بن علي وشيعته.
حيث وثب إليه عبد الله بن عفيف - وكان ضريراً قد ذهبت إحدى عينيه يوم الجمل مع أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)، والأُخرى بصفين معه (عليه السّلام) أيضاً - فقال: يابن مرجانة، إنّ الكذّاب بن الكذّاب أنت وأبوك، والذي ولاّك وأبوه. يابن مرجانة، أتقتلون أبناء النبيين وتكلّمون بكلام الصدّيقين؟!(٢) .
فقال ابن زياد: مَنْ المتكلّم؟ فقال: أنا المتكلّم يا عدوّ الله! أتقتل الذريّة الطاهرة الذين قد أذهب الله عنهم الرجس في كتابه، وتزعم أنّك على دين
____________________
١ - تاريخ الطبري ٤/٣٥٦ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/٨٩ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، البداية والنهاية ٨/٢١٣ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، صفة مقتله مأخوذة من كلام أئمّة الشأن، تاريخ دمشق ٦٢/٨٥ في ترجمة نضلة بن عبيد، وغيرها من المصادر.
٢ - تاريخ الطبري ٤/٣٥١ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/٨٣ في أحداث سنة إحدى وستين، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، البداية والنهاية ٨/٢٠٧ - ٢٠٨ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، صفة مقتله مأخوذة من كلام أئمّة الشأن، الفتوح - لابن أعثم ٥/١٤٤ ذكر عبد الله بن عفيف الأزدي ورده على ابن زياد، المحبر/٤٨٠، أنساب الأشراف ٣/٤١٣ مقتل الحسين بن علي (عليهما السّلام)، تذكرة الخواص/٢٥٩، وغيرها من المصادر.
الإسلام؟! وا غوثاه! أين أولاد المهاجرين والأنصار؛ لينتقموا من هذا الطاغية اللعين بن اللعين على لسان رسول الله ربّ العالمين؟(١) .
فإنّ إنكار هذا العبد الصالح وإن كان مهمّاً جداً؛ لأنّه على ملأ من الناس، وبلهجة شديدة، إلّا إنّه شخص واحد مستميت، وقد قُتل فعلاً، وصُلب(٢) بعد معركة طويلة قتل فيها جماعة(٣) . شكر الله سعيه ورضي عنه وأرضاه.
إنكار امرأة من آل بكر بن وائل
ومثله ما روي من أنّ امرأة من آل بكر بن وائل كانت مع زوجها في المعركة، فلمّا نظرت العسكر يسلب العائلة الكريمة أخذت سيفاً، وأقبلت نحو الفسطاط وقالت: يا آل بكر بن وائل! أتُسلب بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! لا حكم إلّا الله. يا لثارات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فردّها زوجها إلى رحله(٤) .
فإنّها امرأة واحدة انهارت لهول ما رأت، وكذا غيرها ممّن أنكر بصورة فردية من دون أن يكون لإنكاره ظهور على الصعيد العام.
وإنّما نعني عامّة الناس في المصرين المدينة المنوّرة والكوفة؛ لأنّهما اللذان
____________________
١ - مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٥٣، واللفظ له، الفتوح - لابن أعثم ٥/١٤٤ ذكر عبد الله بن عفيف الأزدي ورده على ابن زياد، اللهوف في قتلى الطفوف/٩٦، وغيرها من المصادر.
٢ - تاريخ الطبري ٤/٣٥١ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، الكامل في التاريخ ٤/٨٣ في أحداث سنة إحدى وستين، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، البداية والنهاية ٨/٢٠٨ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، صفة مقتله مأخوذة من كلام أئمّة الشأن، المحبر/٤٨٠، الفتوح - لابن أعثم ٥/١٤٥ ذكر عبد الله بن عفيف الأزدي ورده على ابن زياد، أنساب الأشراف ٣/٤١٤ مقتل الحسين بن علي (عليهما السّلام)، اللهوف في قتلى الطفوف/٩٩، وغيرها من المصادر.
٣ - الفتوح - لابن أعثم ٥/١٤٥ ذكر عبد الله بن عفيف الأزدي ورده على ابن زياد، أنساب الأشراف ٣/٤١٤ مقتل الحسين بن علي (عليهما السّلام)، مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٥٣ - ٥٤، اللهوف في قتلى الطفوف/٩٧، وغيرها من المصادر.
٤ - اللهوف في قتلى الطفوف/٧٨، واللفظ له، مثير الأحزان/٥٨، بحار الأنوار ٤٥/٥٨.
يتيسّر لنا الاطلاع تاريخياً على موقف الناس فيهم.
موقف جمهور أهل الكوفة
فقد استقبل الكوفيون العائلة الكريمة - التي عوملت معاملة الكفّار في السلب والأسر والتشهير - بالبكاء والصراخ، والنوح والتوجّع، والتفجّع والتأسّف(١) ، وقد شقّت النساء جيوبهنَّ على الإمام الحسين (صلوات الله عليه) والتَدَمنَ(٢) .
وعن حاجب ابن زياد أنّه قال: ثمّ أُمر بعلي بن الحسين (عليه السّلام) فُغلَّ، وحُمل مع النسوة والسبايا إلى السجن وكنت معهم، فما مررنا بزقاق إلّا وجدناه مُلئ رجالاً ونساءً يضربون وجوههم ويبكون، فحُبسوا في سجن وطُبق عليهم(٣) .
كما ورد أنّه بعد أن خطبت أُمّ كلثوم (عليها السّلام) ضجّ الناس بالبكاء والنوح، ونشر النساء شعورهنَّ، وخمشنَ وجوههنَّ، وضربنَ خدودهنَّ، ودعونَ بالويل والثبور، وبكى الرجال ونتفوا لحاهم، فلم يُرَ باكٍ وباكية أكثر من ذلك اليوم(٤) .
ولولا حصول الجوّ المناسب والأرضية الصالحة لما تيسّر لها ولا لغيرها من أفراد العائلة الكريمة الخطبة في الناس بعد أن أُدخلوا إلى الكوفة أسرى يُراد
____________________
١ - بلاغات النساء/٢٣ كلام أُمّ كلثوم بنت علي (عليها السّلام)، الفتوح - لابن أعثم ٥/١٣٩ تسمية مَنْ قُتل بين يدي الحسين من ولده وإخوانه وبني عمّه (رضي الله عنهم)، تاريخ اليعقوبي ٢/٢٤٥ مقتل الحسين بن علي، مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٤٠، مطالب السؤول/٤٠٣، الأمالي - للمفيد/٣٢١، الأمالي - للطوسي/٩٢، اللهوف في قتلى الطفوف/٨٦، بحار الأنوار ٤٥/١٦٢، وغيرها من المصادر.
٢ - بلاغات النساء/٢٣ - ٢٤ كلام أُمّ كلثوم بنت علي (عليها السّلام)، جمهرة خطب العرب ٢/١٣٤خطبة السيدة أُمّ كلثوم بنت علي في أهل الكوفة بعد مقتل الحسين (عليه السّلام)، الأمالي - للمفيد/٣٢١، الأمالي - للطوسي/٩١، والتدام النساء: ضربهنَّ وجوههنَّ في المأتم.
٣ - الأمالي - للصدوق/١٤٦ مجلس ٣١ رقم الحديث ٣، وعنه في بحار الأنوار ٤٥/١٥٤.
٤ - اللهوف في قتلى الطفوف ٩١ - ٩٢، وذكر قريباً من ذلك الخوارزمي في مقتله ٢/٤١.
التشهير بهم وتوهينهم.
على أنّه يبدو من بعض خُطب أهل البيت (عليهم السّلام) في الكوفة أنّ السلطة قد سبقت ركب الأسرى من العائلة الثاكلة ببعض مظاهر التبجّح بالواقعة؛ في محاولة منها للتشهير بها، وإظهار السرور على الصعيد العام بما أوقعته بها.
فقد ورد في خطبة فاطمة الصغرى في الكوفة حال السبي قولها: تبّاً لكم يا أهل الكوفة! كم تراث(١) لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قِبَلكم، وذحوله(٢) لديكم؟! ثمّ غدرتم بأخيه علي بن أبي طالب (عليه السّلام) جدّي وبنيه وعترة النبي الطيبين الأخيار. وافتخر بذلك مفتخر، فقال:
نحنُ قتلنا علياً وبني علي |
بسيوفٍ هنديةٍ ورماحِ |
|
وسبينا نساءَهم سبي ترك |
ونطحناهمُ فأيّ نطاحِ |
فقالت: بفيك أيّها القائل الكثكث، ولك الاثلب...(٣) .
ولكنّ ذلك لم يقوَ على كبح جماح عواطف جمهور الناس نحو العائلة الكريمة وأهل البيت (صلوات الله عليهم)، وإظهار التعاطف معهم، والبكاء عليهم، والتفجّع لهم.
وهكذا الحال لما أُخرجوا من الكوفة إلى الشام، فقد روى ابن سعد بسنده عن الإمام زين العابدين (صلوات الله عليه) أنّه قال: «حُملنا من الكوفة إلى يزيد بن معاوية، فغصّت طرق الكوفة بالناس يبكون، فذهب عامّة الليل ما يقدرون أن يجوزوا بنا لكثرة الناس. فقلت: هؤلاء الذين قتلونا، وهم الآن
____________________
١ - التراث: ما يخلفه الرجل لورثته، وفي مثير الأحزان/٦٨: أيّ ترات، بالتاء المثناة. وترات جمع تِرة: وهي إصابة الشخص بظلم أو مكروه، وهو أنسب بالمقام.
٢ - الذحول جمع ذحل وهو الثأر.
٣ - الاحتجاج ٢/٢٨، واللفظ له، اللهوف في قتلى الطفوف/٩٠، مثير الأحزان/٦٨، والكثكث: هو التراب وفتات الحجارة. وكذا الأثلب والإثلب.
يبكون»(١) .
موقف جمهور أهل المدينة المنوّرة
أمّا في المدينة المنوّرة فإنّه لما وصل الخبر بقتل الإمام الحسين (عليه السّلام) لعمرو بن سعد بن العاص الأشدق أمر المنادي أن يعلن بقتله في أزقّة المدينة، فلم يسمع ذلك اليوم واعية مثل واعية بني هاشم، واتصلت الصيحة بدار الأشدق، فضحك شامتاً، وأنشد:
عجّت نساءُ بني زيادٍ عجة |
كعجيجِ نسوتنا غداةَ الأرنبِ(٢) |
قال ابن طاووس: فعظمت واعية بني هاشم، وأقاموا سنن المصائب والمآتم(٣) .
وقال اليعقوبي: «وكان أوّل صارخة صرخت في المدينة أُمّ سلمة زوج رسول الله، كان دفع إليها قارورة فيها تربة، وقال لها: إنّ جبرئيل أعلمني أنّ أُمّتي تقتل الحسين. قالت: وأعطاني هذه التربة، وقال لي: إذا صارت دماً عبيطاً فاعلمي أنّ الحسين قد قُتل... فلمّا رأتها قد صارت دماً صاحت: وا حسيناه! وا ابن رسول الله! وتصارخت النساء من كلّ ناحية حتى ارتفعت المدينة بالرجّة التي ما سمع بمثلها قطّ»(٤) .
____________________
١ - ترجمة الإمام الحسين (عليه السّلام) من طبقات ابن سعد/٨٩ ح ٣١٣.
٢ - تاريخ الطبري ٤/٣٥٦ - ٣٥٧ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، الكامل في التاريخ ٤/٨٩ في أحداث سنة إحدى وستين، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، الإرشاد ٢/١٢٣، مثير الأحزان/٧٤، وغيرها من المصادر.
٣ - اللهوف في قتلى الطفوف/٩٩.
١ - تاريخ اليعقوبي ٢/٢٤٦ مقتل الحسين بن علي.
وقد استفاضت أحاديث الشيعة والجمهور المتضمّنة دفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأُمّ سلمة (رضي الله عنها) تربة، وأعلمها أنّ الإمام الحسين (صلوات الله عليه) إذا قُتل تصير دماً، وأنّها علمت =
وخرجت بنت عقيل في جماعة من نساء قومها حتى انتهت إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلاذت به، وشهقت عنده، ثمّ التفتت إلى المهاجرين والأنصار وأنشدت:
ماذا تقولونَ إن قالَ النبي لكم |
يومَ الحسابِ وصدقَ القولِ مسموعُ |
|
خذلتموا عترتي أو كنتمُ غيب |
والحقّ عند وليّ الأمرِ مجموعُ |
|
أسلمتموهم بأيدي الظالمينَ فم |
منكم لهُ اليومَ عندَ الله مشفوعُ |
|
ما كانَ عندَ غداةِ الطفِّ إذ حضروا |
تلكَ المنايا ولا عنهنَّ مدفوعُ |
فأبكت مَنْ حضر، ولم يُرَ باكٍ وباكية أكثر من ذلك اليوم(١) .
____________________
= بقتله (عليه السّلام) حينما رأت أنّ تلك التربة صارت دماً.
قال ابن الأثير: فأعلمت الناس بقتله أيضاً. الكامل في التاريخ ٤/٩٣ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر أسماء مَنْ قُتل معه، وراجع حديث التربة المذكور في مجمع الزوائد ٩/١٨٩ كتاب المناقب، باب مناقب الحسين بن علي (عليهما السّلام)، والمعجم الكبير ٣/١٠٨ مسند الحسين بن علي، ذكر مولده وصفته، وتاريخ دمشق ١٤/١٩٣ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، وتهذيب الكمال ٦/٤٠٩ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، وتهذيب التهذيب ٢/٣٠١ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، والوافي بالوفيات ١٢/٢٦٣ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، وإمتاع الأسماع ١٢/٢٣٨، والفتوح - لابن أعثم ٤/٣٢٧ ابتداء أخبار مقتل مسلم بن عقيل والحسين بن علي وولده وشيعته من ورائه وأهل السنّة وما ذكروا في ذلك من الاختلاف، وغيرها من المصادر الكثيرة.
١ - الأمالي - للمفيد/٣١٩، الأمالي - للطوسي/٩٠، مناقب آل أبي طالب - لابن شهرآشوب/٢٦٢.
وعن أبي الكنود قال: ولما أُتي أهل المدينة مقتل الحسين خرجت ابنة عقيل بن أبي طالب ومعها نساؤها، وهي حاسرة تلوي بثوبها وتقول:
ماذا تقولونَ إن قالَ النبي لكم |
ماذا فعلتم وأنتم آخرُ الأُممِ |
|
بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي |
منهم أُسارى ومنهم ضُرّجوا بدمِ |
تاريخ الطبري ٤/٣٥٧ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/٨٨ - ٨٩ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، البداية والنهاية ٨/٢١٥ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، صفة مقتله مأخوذة من كلام أئمّة الشأن، المعجم الكبير ٣/١١٨ مسند الحسين بن علي، ذكر مولده وصفته، مجمع الزوائد ٩/١٩٩ - ٢٠٠ =
ولعلّه؛ لذا أمر عمرو بن سعيد بن العاص بعد قتل الإمام الحسين (عليه السّلام) صاحب شرطته عمرو بن الزبير أن يهدم دور بني هاشم ففعل، وبلغ منهم كلّ مبلغ، وهدم دار ابن مطيع، وضرب الناس ضرباً شديداً، فهربوا منه إلى ابن الزبير(١) .
حيث لا يبعد أن يكون ذلك منه ردّاً على الناس وعقوبة لهم؛ لأنّهم تحدّوا بعواطفهم موقف السلطة، وإظهاراً لصرامتها في ذلك، وردّاً لهيبتها واعتبارها.
موقف أهل المدينة عند رجوع العائلة الثاكلة إليه
أمّا بعد رجوع ركب العائلة مكرّماً إلى المدينة - نتيجة تراجع السلطة عن موقفها، كما يأتي - فقد اندفع الناس في إظهار عواطفهم.
فعن الواقدي أنّه لم يبقَ بالمدينة أحد، وخرجوا يضجّون بالبكاء(٢) . وقال الخوارزمي: عجت نساء بني هاشم، وصارت المدينة صيحة واحدة(٣) .
وروي أنّ الإمام زين العابدين (عليه السّلام) بعث بشر بن حذلم ينعى الإمام الحسين (عليه السّلام) لأهل المدينة، ويخبرهم بأنّ ركبه قد نزل بساحتهم، فخرج الناس يهرعون، ولم تبقَ مخدّرة ولا محجّبة إلّا برزنَ من خدورهنّ يدعونَ بالويل والثبور، وضجّت المدينة بالبكاء، فلم يُرَ باكٍ أكثر من ذلك اليوم.، وخرجوا
____________________
=كتاب المناقب، باب مناقب الحسين بن علي (عليهما السّلام)، تاريخ دمشق ٦٩/١٧٨ في ترجمة زينب الكبرى بنت علي بن أبي طالب، وغيرها من المصادر.
١ - الأغاني ٥/٧٥ ذكر عبيد الله بن قيس الرقيات، وقد تعرّض لبعض ذلك الزركلي في الأعلام ٧/٢٤٨ في ترجمة مصعب بن الزبير.
٢ - ينابيع المودّة ٣/٤٧، تذكرة الخواص/٢٦٧ حديث الجمال التي حمل عليها الرأس والسبايا.
٣ - مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٧٦.
لاستقبال العائلة الثاكلة وقد أخذوا الطرق والمواضع(١) .
موقف الناس في الشام
وحتى الشام فإنّها وإن حُجر عليها ثقافياً، ولم تعرف عموماً غير ثقافة الأمويين، إلّا إنّه كان هناك تململ وإنكار من بعض الخاصة في مجلس يزيد(٢) ، وفي بعض المناطق بتكتّم وحذر شديدين(٣) .
كما إنّ التاريخ قد تضمّن كثيراً من الإنكارات الفردية بصور متفرّقة، وفي مناسبات مختلفة، ومن الطبيعي أنّ ما لم يسجّل منها أكثر.
وقع الحدث في أمصار المسلمين البعيدة
وعلم الله تعالى كيف كان وقع الحدث في أمصار المسلمين الأُخرى التي هي بسبب بعدها عن الأحداث أبعد عن ضغط الطغمة الحاكمة.
ولاسيما إنّ الإمام الحسين (صلوات الله عليه) قد خطا خطوة مهمّة في تعريف المسلمين في أقطار الأرض بمقام أهل البيت (صلوات الله عليهم) في
____________________
١ - اللهوف في قتلى الطفوف/١١٥، مثير الأحزان/٩٥ - ٩٦.
٢ - تاريخ دمشق ٦٨/٩٥ في ترجمة رجل له صحبة، أسد الغابة ٥/٣٨١ في ذكر عبد الواحد بن عبد الله القرشي عن رجل من الصحابة، تهذيب الكمال ٦/٤٢٩ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، سير أعلام النبلاء ٣/٣٠٩ في ترجمة الحسين الشهيد، الجوهرة في نسب الإمام علي وآله/٤٦، ترجمة الإمام الحسين (عليه السّلام) من طبقات ابن سعد/٨٢ ح ٢٩٦، الفتوح - لابن أعثم ٥/١٥٠، ١٥٤ ذكر كتاب عبيد الله بن زياد إلى يزيد بن معاوية وبعثته إليه برأس الحسين بن علي (رضي الله عنهما)، مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٧١ - ٧٣، تذكرة الخواص/٢٦٣، وغيرها من المصادر الكثيرة.
٣ - مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٦١، اللهوف في قتلى الطفوف/١٠٢ - ١٠٣، بحار الأنوار ٤٥/٢٧٣، وغيرها من المصادر.
مؤتمره الذي عقده في الحجّ في أواخر عهد معاوية.
محاولة الإمام الحسين (عليه السّلام) نشر مناقب أهل البيت (عليهم السّلام)
فقد ورد أنّه (عليه السّلام) جمع وجوه مَنْ بقي من المهاجرين والأنصار، وجماعة ممّن يُعرف بالنسك والصلاح من التابعين المنتشرين في الأقطار الإسلامية وخطبهم، فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال (صلوات الله عليه):
«أمّا بعد، فإنّ هذا الطاغية قد فعل بنا وبشيعتنا ما قد رأيتم وعلمتم وشهدتم، وإنّي أُريد أن أسألكم عن شيء، فإن صدقت فصدّقوني، وإن كذبت فكذّبوني.
أسألكم بحقّ الله عليكم، وحقّ رسول الله، وحقّ قرابتي من نبيّكم، لما سيّرتم مقامي هذا، ووصفتم مقالتي، ودعوتم أجمعين في أنصاركم من قبائلكم مَنْ أمنتم من الناس ووثقتم به، فادعوهم إلى ما تعلمون من حقنا؛ فإنّي أتخوّف أن يُدرس هذا الأمر، ويذهب الحقّ ويُغلَب،( وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ) (١) ».
ثمّ ما ترك (صلوات الله عليه) شيئاً ممّا أنزل الله تعالى فيهم من القرآن إلّا تلاه وفسّره، ولا شيئاً ممّا قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أبيه وأُمّه وأخيه وفي نفسه وأهل بيته (صلوات الله عليهم) إلّا رواه.
وفي كلّ ذلك يقول مَنْ شهد الحديث من الصحابة: اللّهمّ نعم، وقد سمعنا وشهدنا. ويقول التابعي: اللّهمّ قد حدّثني به مَنْ أصدقه وأئتمنه من الصحابة. فقال (عليه السّلام): «أُنشدكم الله إلّا حدّثتم به مَنْ تثقون به وبدينه». ثمّ تفرّقوا على ذلك(٢) .
____________________
١ - سورة الصف/٨.
٢ - كتاب سليم بن قيس الهلالي/٣٢٠ - ٣٢١، الاحتجاج ٢/١٨ - ١٩.
جهود العائلة الثاكلة في كشف الحقيقة وتهييج العواطف
أمّا العائلة الثاكلة التي لم يكن فيها من الرجال سوى الإمام زين العابدين (صلوات الله عليه) الذي أنهكه المرض فقد رأت الأرضية الصالحة لبيان الحقيقة، والجوّ المناسب لذلك، فاستثمرت الظلامة لتهييج العواطف.
وقد تيسّر لها في هذه المدّة الطويلة أن تكشف الحقيقة، وتُعلن عن شرف النهضة، ورفعة مقام أهل البيت (صلوات الله عليهم)، وعن فداحة المصاب، وعظم الجريمة، بنحو ينبّه الغافلين، ويهيج العواطف، ويصدع القلوب، ويترك أعمق الأثر في النفوس.
كان ذلك منها في كربلاء قُبيل قتل الإمام الحسين (عليه السّلام)(١) وبعد
____________________
١ - تاريخ الطبري ٤/٣٤٥ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، الكامل في التاريخ ٤/٧٨ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، البداية والنهاية ٨/٢٠٤ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، صفة مقتله مأخوذة من كلام أئمّة الشأن، الإرشاد ٢/١١٢، وغيرها من المصادر.
وقد قال الطبري في حديث رواه: وعُتب على عبد الله بن عمار بعد ذلك مشهده قتل الحسين، فقال عبد الله بن عمار: إنّ لي عند بني هاشم ليداً. قلنا له: وما يدك عندهم؟ قال: حملت على حسين بالرمح فانتهيت إليه، فوالله لو شئت لطعنته، ثمّ انصرفت عنه غير بعيد، وقلت: ما أصنع بأن أتولّى قتله؟! يقتله غيري. قال: فشدّ عليه رجّالة ممّن عن يمينه وشماله، فحمل على مَنْ عن يمينه حتى أُذعروا، وعلى مَنْ عن شماله حتى أُذعروا، وعليه قميص له من خز وهو معتم. قال: فوالله، ما رأيت مكسوراً قطّ قد قُتل ولده وأهل بيته وأصحابه أربط جأشاً ولا أمضى جناناً منه، ولا أجرأ مقدماً. والله، ما رأيت قبله ولا بعده مثله؛ إن كانت الرجّالة لتنكشف من عن يمينه وشماله انكشاف المعزى إذا شدّ فيها الذئب. قال: فوالله، إنّه لكذلك، إذ خرجت زينب ابنة فاطمة أُخته... وهي تقول: ليت السماء تطابقت على الأرض. وقد دنا عمر بن سعد من حسين، فقالت: يا عمر بن سعد، أُيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟! قال: فكأنّي أنظر إلى دموع عمر وهى تسيل على خدّيه ولحيته. قال: وصرف بوجهه عنها.
قتله(١) ، وفي الكوفة على ملأ من الناس(٢) ، وفي مجلس ابن زياد(٣) ،
____________________
١ - مثير الأحزان/٥٩، مناقب آل أبي طالب - لابن شهرآشوب ٣/٢٦٠، اللهوف في قتلى الطفوف/٧٨ - ٧٩.
ومن ذلك ما رواه الطبري عن قرّة بن قيس التميمي قال: نظرت إلى تلك النسوة لما مررن بحسين وأهله وولده صحنَ ولطمنَ وجوههنَّ. قال: فاعترضتهنَّ على فرس، فما رأيت منظراً من نسوة قطّ كان أحسن من منظر رأيته منهنَّ ذلك. والله، لهنَّ أحسن من مها يبرين. قال: فما نسيت من الأشياء لا أنسى قول زينب ابنة فاطمة حين مرّت بأخيها الحسين صريعاً وهي تقول: يا محمداه! يا محمداه! صلّى عليك ملائكة السماء، هذا الحسين بالعراء، مرمّل بالدماء، مقطّع الأعضاء. يا محمداه! وبناتك سبايا، وذريّتك مقتّلة تسفى عليها الصبا. قال: فأبكت والله كلّ عدوّ وصديق. تاريخ الطبري ٤/٣٤٨ - ٣٤٩ في أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة.
٢ - تقدّم التعرّض لبعض ذلك عند ذكر موقف أهل الكوفة حين استقبلوا العائلة الثاكلة. راجع ملحق رقم ٣.
٣ - فقد نقل ابن نما عن حميد بن مسلم أنّه قال: لما أُدخل رهط الحسين (عليه السّلام) على عبيد الله بن زياد - لعنهما الله - أذن للناس إذناً عاماً. وجيء بالرأس فوضِع بين يديه، وكانت زينب بنت علي (عليهما السّلام) قد لبست أردأ ثيابها وهي متنكّرة، فسأل عبيد الله عنها ثلاث مرّات، وهي لا تتكلّم. قيل له: إنّها زينب بنت علي بن أبي طالب، فاقبل عليها، وقال: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم، وأكذب أحدوثتكم. فقالت: الحمد الذي أكرمنا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وطهرنا تطهيراً، [لا كما تقول أنت. تاريخ الطبري] إنّما يُفتضح الفاسق، ويُكذب الفاجر، وهو غيرنا. فقال: كيف رأيتِ صنع الله بأهل بيتكِ؟ قالت: ما رأيت إلّا جميلاً، هؤلاء قوم كُتب عليهم القتل؛ فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم، فتُحاج وتُخاصم، فانظر لمَنْ الفلج، هبلتك أُمّك يابن مرجانة.
فغضب ابن زياد، [وكأنّه هم بها. اللهوف، مقتل الحسين (عليه السّلام) ]، وقال له عمرو بن حريث: إنّها امرأة، ولا تُؤاخذ بشيء من منطقها. فقال ابن زياد: لقد شفاني الله من طغاتكِ والعصاة المردة من أهل بيتكِ. فبكت، ثمّ قالت: لقد قتلت كهلي، [وأبّرت أهلي. الطبري] وقطعت فرعي، واجتثثت أصلي. فإن تشفّيت بهذا فقد اشتفيت. مثير الأحزان/٧٠. راجع الأمالي - للصدوق/٢٢٩، والإرشاد ٢/١١٥، وإعلام الورى بأعلام الهدى ج:١ =
وفي الشام(١) ، وفي مجلس يزيد(٢) .
وإنّ من أشدّ ذلك خطبة العقيلة زينب (عليها السّلام) بنت أمير المؤمنين (صلوات
____________________
= ص: ٤٧١ - ٤٧٢، واللهوف في قتلى الطفوف/٩٣ - ٩٤، وتجده مع اختلاف يسير في تاريخ الطبري ٤/٣٤٩ - ٣٥٠ في أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، والكامل في التاريخ ٤/٨١ - ٨٢ في أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (عليه السّلام)، والبداية والنهاية ٨/٢١٠ في أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، صفة مقتله مأخوذة من كلام أئمّة الشأن، والفتوح - لابن أعثم ٥/١٤٢ ذكر دخول القوم على عبيد الله بن زياد، ومقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٤٢، وغيرها من المصادر.
١ - قال الخوارزمي: ثمّ أُتي بهم حتى أقيموا على درج باب المسجد الجامع حيث يُقام السبي، وإذا شيخ أقبل حتى دنا منهم قال: الحمد لله الذي قتلكم وأهلككم، وأراح العباد من رجالكم، وأمكن أمير المؤمنين منكم. فقال له علي بن الحسين (عليه السّلام): «يا شيخ، هل قرأت القرآن؟». قال: نعم. قال: «هل قرأت هذه الآية( قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ) ؟». قال الشيخ: قرأتها. قال: «فنحن القربى يا شيخ. وهل قرأت هذه الآية( إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) ؟». قال: نعم. قال: «فنحن أهل البيت الذي خُصصنا بآية الطهارة». فبقي الشيخ ساكتاً ساعة نادماً على ما تكلّم به، ثمّ رفع رأسه إلى السماء فقال: اللّهمّ إنّي أتوب إليك من بغض هؤلاء، وإنّي أبرأ إليك من عدوّ محمد وآل محمد من الجنّ والإنس.
مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٦١ - ٦٢، وقد ذكر القصّة باختلاف يسير في اللهوف في قتلى الطفوف/١٠٢ - ١٠٣، وفي تفسير الطبري ٢٥/٣٣، وتفسير الثعلبي ٨/٣١١، وتفسير ابن كثير ٤/١٢١، وروح المعاني - للآلوسي ٢٥/٣١، والدرّ المنثور ٦/٧، وغيرها من المصادر.
٢ - قال ابن الجوزي: وكان علي بن الحسين والنساء موثقين في الحبال، فناداه علي: يا يزيد، ما ظنّك برسول الله لو رآنا موثقين في الحبال، عرايا على أقتاب الجمال؟! فلم يبقَ في القوم إلّا مَنْ بكى. تذكرة الخواص/١٦٢، واللفظ له، الأنوار النعمانية ٣/٢٥١ نور في بعض أحوال واقعة الطفوف، اللهوف في قتلى الطفوف/١٠١.
وروى الخوارزمي كلام له (عليه السّلام) مع يزيد أشدّ من هذا لا يسعنا ذكره لطوله. مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٦٣.
الله عليه) في مجلس يزيد حينما تبجّح بقتله للحسين (عليه السّلام)، وأنشد الأبيات المتقدّمة، حيث إنّها لم تقتصر على بيان ظلامة أهل البيت (صلوات الله عليهم) وفداحة المصاب، بل زادت على ذلك بتبكيت يزيد وتكفيره، والتأكيد على هوانه على الله تعالى، وعلى خسّته وخسّة أصوله وعراقتهم في الكفر، ووعده بسوء العاقبة في الدنيا والآخرة، والتأكيد على أنّ العاقبة لأهل البيت (صلوات الله عليهم).
كلّ ذلك ببيان فريد، ومنطق رصين يبهر العقول، كأنّها تُفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين، وأُمّها الصديقة الزهراء (صلوات الله عليهم)(١) .
كما خطب الإمام زين العابدين (عليه السّلام) خطبة طويلة أبكى بها العيون، وأوجل فيها القلوب، انتسب فيها لآبائه الكرام (صلوات الله عليهم)، وأشاد برفيع مقامهم وبمواقفهم وجهادهم، وعرج على مصاب أبيه (عليه السّلام)، فقال: «أنا ابن المقتول ظلماً، أنا ابن المحزوز الرأس من القفا، أنا ابن العطشان حتى قضى، أنا ابن طريح كربلاء، أنا ابن مسلوب العمامة والرداء، أنا ابن مَنْ بكت عليه ملائكة السماء، أنا ابن مَنْ ناحت عليه الجنّ في الأرض والطير في الهواء...».
فضجّ الناس بالبكاء، وخشي يزيد من الفتنة، فاضطرّ إلى قطع خطبته بأن طلب من المؤذّن أن يؤذّن، فلمّا انتهى المؤذّن إلى قوله: أشهد أنّ محمداً رسول الله، التفت (عليه السّلام) إلى يزيد، وقال: «يا يزيد، محمد هذا جدّي أم جدّك؟ فإن زعمت أنّه جدّك فقد كذبت، وإن قلت إنّه جدّي فلِمَ قتلت عترته؟!»(٢) .
____________________
١ - راجع ملحق رقم ٤، وتقدّم بعض خطبتها المذكورة في/٨٠، ويأتي لها معه كلام آخر في/٢٤٢.
٢ - راجع ملحق رقم ٥.
فاجعة الطفّ أشدّ جرائم يزيد وقعاً في نفوس المسلمين
وبالرغم من أنّ يزيد كما قام في السنة الأولى من حكمه بفاجعة الطفّ، قام في السنة الثانية بواقعة الحرّة الفظيعة التي انتُهكت فيها حرمة المدينة المنوّرة وحرمة أهلها على أبشع وجه، وبوحشية مسرفة، وقام في السنة الرابعة باستباحة حرم الله (عزّ وجلّ) ومكّة المكرّمة، ورُمي المسجد الحرام والكعبة المعظمة بالمنجنيق، إلّا أنّه يبدو أنّ فاجعة الطفّ هي الأشدّ وقعاً في نفوس المسلمين.
فقد ورد عن الزبير بن بكار(١) ، وعن البيهقي صاحب التاريخ(٢) أنّ عام قتل الحسين (عليه السّلام) سُمّي عام الحزن، كما ذكر البكري أنّهم كانوا يقولون: ضحّى بنو حرب بالدين يوم كربلاء، وضحّى بنو مروان بالمروءة يوم العقر(٣) .
ندم جماعة من المشاركين في المعركة
كما صرّح غير واحد بالندم والأسف لاشتراكهم في المعركة، وقيامهم بهذه الجريمة الكبرى، وشعورهم بالخزي والعار في الدنيا، وانتظارهم عظيم العقاب والنكال في الآخرة.
ندم عمر بن سعد وموقف الناس منه
فقد قام عمر بن سعد من عند ابن زياد يريد منزله إلى أهله، وهو يقول في طريقه: ما رجع أحد بمثل ما رجعت، أطعت الفاسق ابن زياد، وعصيت
____________________
١ - ملحقات إحقاق الحقّ ٣٣/٦٩٩ عن مختصر تذكرة القرطبي - للشعراني/٢٢٢.
٢ - مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٤٠.
٣ - معجم ما استعجم ٣/٩٥٠ عند ذكر (العقر)، ومثله مع اختلاف يسير في تاريخ الإسلام ٧/٨ في حوادث سنة اثنتين ومئة، ووفيات الأعيان ٦/٣٠٨، و٤/١٠٩ وقد نسبه فيه إلى كثير، وكذا نسبه في الوافي بالوفيات ٢٤/٢٤٨.
الحاكم العدل، وقطعت القرابة الشريفة(١) . وهجره الناس. وكان كلّما مرّ على ملأ من الناس أعرضوا عنه، وكلّما دخل المسجد خرج الناس منه، وكلّ مَنْ رآه قد سبّه؛ فلزم بيته إلى أن قُتل(٢) .
ومرّ يوماً بمجلس بني نهد حين قتل الحسين (عليه السّلام) فسلّم، فلم يردّوا عليه السّلام، فلّما جاز قال:
أتيتُ الذي لم يأتِ قبلي ابن حرّة |
فنفسي ما أحرت وقومي أذلّتِ(٣) |
وقال رضي بن منقذ العبدي الذي اشتبك مع برير بن خضير (رضي الله عنه) فصرعه برير، وأنعم عليه كعب بن جابر فاستنقذه بعد أن قتل بريراً:
ولو شاء ربّي ما شهدتُ قتالهم |
ولا جعلَ النعماءَ عندي ابن جابرِ |
|
لقد كانَ ذاكَ اليومُ عاراً وسبة |
تعيّرهُ الأبناءُ بعدَ المعاشرِ |
|
فيا ليتَ أنّي كنتُ من قبلِ قتله |
ويومَ حسينٍ كنتُ في رمسِ قابرِ(٤) |
وسُمع شبث بن ربعي في إمارة مصعب يقول: لا يُعطي الله أهل هذا المصر خيراً أبداً، ولا يسدّدهم لرشد؛ ألا تعجبون أنّا قاتلنا مع علي بن أبي طالب، ومع ابنه من بعده آل أبي سفيان خمس سنين، ثمّ عدونا على ابنه - وهو خير أهل الأرض - نقاتله مع آل معاوية وابن سُمية الزانية؟! ضلال يا لك من ضلال!(٥) .
____________________
١ - تذكرة الخواص/٢٥٩، أنساب الأشراف ٣/٤١٤ - ٤١٥ مقتل الحسين بن علي (عليهم السّلام)، الأخبار الطوال/٢٦٠ نهاية الحسين.
٢ - تذكرة الخواص/٢٥٩.
٣ - تاريخ دمشق ٤٥/٥٤ في ترجمة عمر بن سعد، واللفظ له، ترجمة الإمام الحسين (عليه السّلام) من طبقات ابن سعد/٨٨ ح ٣٠٧ - ٣٠٨.
٤ - تاريخ الطبري ٤/٣٣٠ في أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة.
٥ - تاريخ الطبري ٤/٣٣٢ في أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/٦٨ - ٦٩ في أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه).
وقال أبو مخنف: حدّثني نمير بن وعلة أنّ أيوب بن مشرح الخيواني كان يقول: أنا والله عقرت بالحرّ بن يزيد فرسه...، فقال له أشياخ من الحي: أنت قتلته؟ قال: لا والله ما أنا قتلته، ولكن قتله غيري، وما أحبّ أنّي قتلته. فقال له أبو الودّاك: ولِمَ؟ قال: إنّه كان زعموا من الصالحين. فوالله، لئن كان إثماً لأن ألقى الله بإثم الجراحة والموقف أحبّ إليّ من أن ألقاه بإثم قتل أحد منهم...(١) .
ندم جماعة لتركهم نصرة الإمام الحسين (عليه السّلام)
وأمّا الذين ندموا بعد ذلك لتركهم نصرة الإمام الحسين (صلوات الله عليه) فكثيرون، لا يسعنا استقصاؤهم، وقد تقدّم قول البراء بن عازب: أعظم بها حسرة؛ إذ لم أشهده وأُقتل دونه(٢) .
وذكروا أنّ عبد الله بن الحرّ الجعفي طلب منه الإمام الحسين (عليه السّلام) أن ينصره فأبى ذلك واعتزل(٣) ، وقد أنّبَه ابن زياد على عدم قتاله للإمام الحسين (عليه السّلام) في حديث طويل له معه حينما دخل عليه، ثمّ خرج ابن الحرّ من مجلس ابن زياد ومضى إلى كربلاء، فنظر إلى مصارع القوم فاستغفر لهم هو وأصحابه، ثمّ مضى حتى نزل المدائن. وقال في ذلك:
يقولُ أميرٌ غادرٌ حقّ غادر |
ألا كنتَ قاتلتَ الشهيدَ ابن فاطمه |
|
فيا ندمي أن لا أكونَ نصرته |
إلا كلّ نفسٍ لا تسدّدُ نادمه |
|
وإنّي لأنّي لم أكن من حماته |
لذو حسرةٍ ما إن تُفارقُ لازمه |
____________________
١ - تاريخ الطبري ٤/٣٣٣ في أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة.
٢ - تقدّم في/٢٥.
٣ - تاريخ دمشق ٣٧/٤٢١ في ترجمة عبيد الله بن الحرّ بن عمرو، الفتوح - لابن أعثم ٦/٣٠١ ابتداء خبر عبيد الله بن الحرّ الجعفي، ترجمة الإمام الحسين (عليه السّلام) من طبقات ابن سعد/٩٣ في تتمة حديث سابق بعد حديث برقم ٣٢٩.
في أبيات كثيرة يرثي بها الإمام الحسين (عليه السّلام) وأصحابه، ويؤكّد على شدّة جريمة قتلهم(١) ، وله شعر آخر يتضمّن ندمه وحسرته لتقاعسه عن نصره(٢) .
كما إنّ الظاهر أنّ كثيراً من التوّابين قد ندموا على ترك نَصره (عليه السّلام) مع قدرتهم عليه، بل هم إنّما سمّوا بالتوّابين لذلك، وإن كان الظاهر أنّ كثيراً منهم عجز عن نصر الإمام الحسين (صلوات الله عليه)؛ لأنّ ابن زياد قد سجنه، أو لأنّه قد سدّ الطرق بنحو يتعذّر عليه الوصول إلى الإمام الحسين (عليه السّلام)، كما أشرنا إلى ذلك في المقدّمة.
استغلال المعارضة للفاجعة ضدّ الحكم الأموي
هذا كلّه مضافاً إلى أنّ الجريمة بأبعادها الواقعية والعاطفية قد استغلّت على أتمّ وجوه الاستغلال من قِبَل المعارضة.
وأظهرها في ذلك الوقت عبد الله بن الزبير العدوّ اللدود لأهل البيت (صلوات الله عليهم) ولعموم بني هاشم، كما تشهد بذلك مواقفه المشهورة، وقد أشرنا لبعضها في المقدّمة(٣) ، ويأتي الإشارة لبعضها في الموضع المناسب.
ومع ذلك فقد حاول أن يستغلّ الفاجعة لصالحه؛ فقد كان في جملة كلامه - بعد أن ذمّ أهل العراق عامّة والكوفة خاصّة - أن ذكر الإمام الحسين (عليه السّلام) فقال: ولكنّه اختار الميتة الكريمة على الحياة الذميمة، فرحم الله حسيناً وأخزى قاتل
____________________
١ - تاريخ الطبري ٤/٣٥٩ - ٣٦٠ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، واللفظ له، البداية والنهاية ٨/٢٢٩ في شيء من أشعاره التي رويت عنه، تاريخ دمشق ٣٧/٤٢٠ في ترجمة عبيد الله بن الحر بن عمرو، الفتوح - لابن أعثم ٦/٣٠٢ ابتداء خبر عبيد الله بن الحرّ الجعفي.
٢ - تاريخ دمشق ٣٧/٤٢١ في ترجمة عبيد الله بن الحرّ بن عمرو، ترجمة الإمام الحسين (عليه السّلام) من طبقات ابن سعد/٩٤، ٩٦.
٣ - تقدّم في/٦٤.
حسين...، أفبعد الحسين نطمئن إلى هؤلاء القوم، ونصدّق قولهم، ونقبل لهم عهداً؟! لا ولا نراهم لذلك أهلاً. أما والله، لقد قتلوه طويلاً بالليل قيامه، كثيراً في النهار صيامه، أحقّ بما هم فيه منهم، وأولى به في الدين والفضل. أما والله، ما كان يبدل بالقرآن الغناء، ولا بالبكاء من خشية الله الحداء، ولا بالصيام شرب الحرام، ولا بالمجالس في حلق الذكر الركض في تطلاب الصيد فسوف يلقون غيّاً، يعرض بيزيد.
فثار إليه أصحابه، فقالوا له: أيّها الرجل أظهر بيعتك؛ فإنّه لم يبقَ أحد - إذ هَلك حسين - ينازعك هذا الأمر. وقد كان يبايع سرّاً، ويظهر أنّه عائذ بالبيت. فقال لهم: لا تعجلوا(٢) .
وهكذا حاول أن يجعل من فاجعة الطفّ مبرّراً للامتناع من بيعة يزيد، وإنكار شرعية حكمه، والدعوة للخروج عليه.
ولنكتف بهذا المقدار في بيان ردود الفعل السريعة من قِبَل المسلمين نتيجة هول الفاجعة، ويأتي إن شاء الله تعالى في المبحث الثالث من الفصل الأوّل من المقصد الثاني تمام الكلام في التداعيات اللاحقة للفاجعة.(٢)
____________________
١ - تاريخ الطبري ٤/٣٦٤ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر سبب عزل يزيد عمرو بن سعيد عن المدينة وتوليته عليها الوليد بن عتبة، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/٩٨ - ٩٩ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر ولاية الوليد بن عتبة المدينة والحجاز وعزل عمرو بن سعيد، وقد اقتصر ابن الجوزي على ذكر خطبة ابن الزبير في تذكرة الخواص/٢٦٨.
٢ - راجع ص: ٣٧٣ وما بعدها.
المقام الثاني
في موقف السلطة نتيجة ردّ الفعل المذكور
وانقلاب موقفها من الحدث
ومن عائلة الإمام الحسين (صلوات الله عليه)
من الطبيعي جدّاً أن يكون يزيد قد أوعز لابن زياد بقتل الإمام الحسين (صلوات الله عليه) بعد أن امتنع عن بيعته، واستجاب لطلب شيعته في الكوفة أن يأتيه؛ ليكون هو الخليفة والإمام عليهم.
بل لا يشكّ المنصف في أنّ مثل هذه الجريمة الكبرى لا يمكن أن يقدم عليها ابن زياد لوحده لو لم يكن يزيد من ورائه دافعاً له وداعماً لموقفه.
ولاسيما أنّ ابن زياد قد سبق منه أن قتل سفير الإمام الحسين إلى الكوفة مسلم بن عقيل (عليهما السّلام)، وهاني بن عروة، وأرسل رأسيهما إلى يزيد(١) ، وكان ذلك فاتحة الردّ على موقف الإمام الحسين (عليه السّلام) من يزيد الذي انتدب له ابن زياد، فلو
____________________
١ - الكامل في التاريخ ٤/٣٠٦ أحداث سنة ستين من الهجرة: ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين بن علي ليسير إليهم وقتل مسلم بن عقيل، تاريخ الطبري ٤/٢٨٥ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين (عليه السّلام) للمسير إلى ما قبلهم وأمر مسلم بن عقيل (رضي الله عنه)، أنساب الأشراف ٢/٣٤١ - ٣٤٢ مقتل مسلم بن عقيل، تاريخ الإسلام ٤/١٧١ حوادث سنة ستين من الهجرة، بيعة يزيد، الفتوح - لابن أعثم ٥/٦٩ - ٧٠ ذكر كتاب عبيد الله بن زياد إلى يزيد بن معاوية، الإرشاد ٢/٦٥، وغيرها من المصادر.
لم يكن من رأي يزيد قتل الإمام الحسين (عليه السّلام) لكان عليه إلفات نظر ابن زياد وتحذيره من الاندفاع بالاتجاه المذكور.
شواهد أمر يزيد بقتل الإمام الحسين (عليه السّلام)
على أنّه قد روى غير واحد أنّ يزيد كتب إلى ابن زياد يأمره بقتل الإمام الحسين (عليه السّلام)(١) ، كما يأتي من يزيد الاعتراف بتحمّله تبعة قتله (عليه السّلام)(٢) .
بل عن ابن زياد في الاعتذار عن قتل الإمام الحسين (عليه السّلام) أنّه قال: أمّا قتلي الحسين فإنّه أشار عليّ يزيد بقتله أو قتلي؛ فاخترت قتله(٣) .
وهو المناسب لأمور:
الأوّل: حنق يزيد على الإمام الحسين (صلوات الله عليه) من أيام معاوية؛ لأنّه منع من تزويجه بنت عبد الله بن جعفر(٤) ، ورفض بيعته في أيام معاوية، حيث ردّ على معاوية فيمَنْ ردّ عليه(٥) .
وكان يزيد يضيق من مداراة معاوية للإمام الحسين (عليه السّلام) في بعض المناسبات
____________________
١ - تاريخ اليعقوبي ٢/٢٤٢ أيام يزيد بن معاوية، تاريخ دمشق ١٤/٢١٣ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، الأخبار الطوال/٢٨٤، نور الأبصار/١٤٣، وغيرها من المصادر.
٢ - يأتي في/١٢٨.
٣ - الكامل في التاريخ ٤/١٤٠ في أحداث سنة أربع وستين من الهجرة، ذكر هرب ابن زياد إلى الشام.
٤ - تاريخ دمشق ٥٧/٢٤٥ - ٢٤٦ في ترجمة مروان بن الحكم بن أبي العاص، الكامل ٣/٢٠٨ - ٢٠٩ كتاب معاوية إلى مروان بن الحكم، معجم البلدان ١/٤٦٩ في مادة (بغيبغ).
٥ - تاريخ الطبري ٤/٢٢٦ أحداث سنة ست وخمسين من الهجرة، دعاء معاوية الناس إلى بيعة ابنه يزيد من بعده وجعله ولي العهد، الكامل في التاريخ ٣/٥٠٩، ٥١١ أحداث سنة ست وخمسين من الهجرة، ذكر البيعة ليزيد بولاية العهد، البداية والنهاية ٨/١٦٢ أحداث سنة ستين من الهجرة، قصّة الحسين بن علي وسبب خروجه من مكة في طلب الإمارة ومقتله، الإمامة والسياسة ١/١٥١ قدوم معاوية المدينة على هؤلاء القوم وما كان بينهم من المنازعة، الفتوح - لابن أعثم ٤/٣٤٠ - ٣٤١ ذكر خبر معاوية في خروجه إلى الحج وممّا كان منه بمكة والمدينة إلى رجوعه، وغيرها من المصادر.
ويحمله على مجابهته وردعه، ولا يستجيب له معاوية في ذلك(١) .
الثاني: إنّ يزيد كتب للوليد بن عتبة والي المدينة كتاباً يخبره فيه بموت معاوية، ويأمره بأخذ البيعة من الناس، وأرفقه بكتاب صغير كأنّه أُذن فأرة، وفيه: أمّا بعد، فخذ الحسين، وعبد الله بن عمر، وعبد الرحمن بن أبي بكر، وعبد الله بن الزبير بالبيعة أخذاً عنيفاً ليست فيه رخصة، فمَنْ أبى عليك منهم فاضرب عنقه، وابعث إليّ برأسه، والسّلام(٢) .
نعم، ذكر بعضهم الكتاب هكذا: أمّا بعد، فخذ حسيناً، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير بالبيعة أخذاً شديداً ليست فيه رخصة(٣) . ولو تمّ فهو وإن لم يصرح فيه بالقتل، إلّا إنّه راجع إليه، وإلاّ فكيف يكون الأخذ الشديد من عامل يزيد في مثل هذا الأمر الحساس الذي يتوقّف عليه استقرار حكمه وإحكام سلطانه؟!
____________________
١ - اختيار معرفة الرجال/١٢٤ عند ذكر عمرو بن الحمق، تاريخ دمشق ١٤/٢٠٦ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، تاريخ الإسلام ٥/٦ حوادث سنة واحد وستين من الهجرة، مقتل الحسين، وغيرها من المصادر.
٢ - مقتل الحسين - للخوارزمي ١/١٨٠، واللفظ له، الفتوح - لابن أعثم ٥/٩ ذكر الكتاب إلى أهل البيعة بأخذ البيعة، تاريخ اليعقوبي ٢/٢٤١ أيام يزيد بن معاوية إلّا إنّه اقتصر على الإمام الحسين (عليه السّلام) وعبد الله بن الزبير، ونظيره في مناقب آل أبي طالب - لابن شهر آشوب ٣/٢٤٠، واللهوف في قتلى الطفوف/١٦، وغيرها من المصادر.
٣ - تاريخ الطبري ٤/٢٥٠ أحداث سنة ستين من الهجرة، خلافة يزيد بن معاوية، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/١٤ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر بيعة يزيد، البداية والنهاية ٨/١٥٧ أحداث سنة ستين من الهجرة النبوية، يزيد بن معاوية وما جرى في أيامه، المنتظم ٥/٣٢٣ أحداث سنة ستين من الهجرة، باب ذكر بيعة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان.
وأشار إلى هذا الكتاب الدينوري في الأخبار الطوال/٢٢٧ مبايعة يزيد، أنساب الأشراف ٥/٣١٣ ذكر ما كان من أمر الحسين بن علي وعبد الله بن عمر وابن الزبير في بيعة يزيد بعد موت معاوية بن أبي سفيان، سمط النجوم العوالي ٣/٥٤ بيعة يزيد بن معاوية، تاريخ ابن خلدون ٣/١٩ بيعة يزيد، وغيرها من المصادر.
وقد سبق نظيره ممّنْ هو أكثر تعقّلاً من يزيد وأبعد نظراً منه. ففي أحداث السقيفة هُدّد أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) بالقتل(١) ، وقريب من ذلك كان الموقف من سعد بن عبادة(٢) ، وأخيراً قُتل(٣) ، وفي أحداث الشورى أمر عمر بقتل
____________________
١ - الإمامة والسياسة ١/١٦ كيف كانت بيعة علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه)، شرح نهج البلاغة ٢/٦٠، كتاب سليم بن قيس/١٥٣، الاحتجاج ١/١٠٩، مناقب آل أبي طالب - لابن شهرآشوب ١/٣٨١، بحار الأنوار ٢٨/٣٥٦.
٢ - صحيح البخاري ٨/٢٧ - ٢٨ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردّة، باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت، مسند أحمد ١/٥٦ مسند عمر بن الخطاب، حديث السقيفة، المصنف - لابن أبي شيبة ٨/٥٧٢ كتاب المغازي، ما جاء في خلافة أبي بكر وسيرته في الردّة، المصنف - لعبد الرزاق ٥/٤٤٤ كتاب المغازي، بيعة أبي بكر (رضي الله تعالى عنه) في سقيفة بني ساعدة، صحيح ابن حبان ٢/١٥٠ - ١٥١ باب حق الوالدين، الزجر عن أن يرغب المرء عن أبائه إذ استعمال ذلك ضرب من الكفر، تاريخ دمشق ٣٠/٢٨٣ في ترجمة أبي بكر الصديق، وغيرها من المصادر الكثيرة جدّاً.
٣ - العقد الفريد ٤/٢٤٢ - ٢٤٣ فرش كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم، سقيفة بني ساعدة، أنساب الأشراف ١/٢٩١ تسمية السبعين الذين بايعوا عند العقبة، و٢/٢٧٢ أمر السقيفة.
وقد اتّهم الجنّ بقتله في كلّ من المستدرك على الصحيحين ٣/٢٨٣ كتاب معرفة الصحابة، ذكر مناقب سعد بن عبادة الخزرجي النقيب (رضي الله عنه)، والاستيعاب ٢/٥٩٩ في ترجمة سعد بن عبادة، ومجمع الزوائد ١/٢٠٦ كتاب الطهارة، باب البول قائم، والمعجم الكبير ٦/١٦ في ترجمة سعد بن عبادة الأنصاري، وسير أعلام النبلاء ١/٢٧٧ في ترجمة سعد بن عبادة، وغيرها من المصادر الكثيرة.
وعلّق ابن أبي الحديد على اتّهام الجنّ بقوله: أمّا أنا فلا اعتقد أنّ الجنّ قتلت سعداً، ولا أنّ هذا من شعر الجنّ، ولا أرتاب أنّ البشر قتلوه، وأنّ هذا الشعر شعر البشر، ولكن لم يثبت عندي أنّ أبا بكر أمر خالداً، ولا استبعد أن يكون فعله تلقاء نفسه؛ ليرضي بذلك أبا بكر - وحاشاه - فيكون الإثم على خالد، وأبو بكر برئ من إثمه، وما ذلك من أفعال خالد ببعيد. شرح نهج البلاغة ١٧/٢٢٣ - ٢٢٤.
وقال أيضاً: وقال بعض المتأخّرين:
وما ذنبُ سعدٍ أنّه بالَ قائما |
ولكنّ سعداً لم يُبايع أبا بكر |
|
وقد صبرت عن لذةِ العيشِ أنفس |
وما صبرت عن لذةِ النهي والأمر |
شرح نهج البلاغة ١٠/١١١.
مَنْ يخالف حكمها(١) ، وهُدّد أمير المؤمنين (عليه السّلام) عند بيعة عثمان بذلك(٢) .
وروي أنّه لما أراد معاوية البيعة ليزيد بولاية العهد وامتنع هؤلاء النفر جمعهم في مكة، وبعد أن سمع منهم ما لم يعجبه قال لهم: فإنّي قد أحببت أن أتقدّم إليكم، إنّه قد أُعذر مَنْ أُنذر. إنّي كنت أخطب فيكم فيقوم إليّ القائم منكم فيكذّبني على رؤوس الناس، فأحمل ذلك وأصفح، وإنّي قائم بمقالة فأقسم بالله لئن ردّ أحدكم كلمة في مقامي هذا لا ترجع إليه كلمة غيرها حتى يسبقها السيف إلى رأسه، فلا يبقينَّ رجل إلّا على نفسه.
ثمّ جمع صاحب حرسه بحضرتهم فقال: أقم على رأس كلّ رجل من هؤلاء رجلين، ومع كلّ واحد سيف، فإن ذهب رجل منهم يردّ عليّ كلمة بتصديق أو تكذيب فليضرباه بسيفهما.
____________________
١ - المصنف - لابن أبي شيبة ٨/٥٨٢ كتاب المغازي، ما جاء في خلافة عمر بن الخطاب، صحيح ابن حبان ١٥/٣٣٢ كتاب إخباره صلى الله عليه وآله وسلم عن مناقب الصحابة، مناقب عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)، وصف استشهاده (رضي الله عنه)، تاريخ الطبري ٣/٢٩٤ أحداث سنة ثلاث وعشرين من الهجرة، قصّة الشورى، الكامل في التاريخ ٣/٦٧ أحداث سنة ثلاث وعشرين من الهجرة، ذكر قصّة الشورى، المصنف - لابن أبي شيبة ٨/٥٨٢ كتاب المغازي، ما جاء في خلافة عثمان وقتله، الإمامة والسياسة ١/٢٦ تولية عمر بن الخطاب الستة الشورى وعهده إليهم، تاريخ المدينة ٣/٩٢٥، كنز العمال ١٢/٦٩٤ ح ٣٦٠٧٦، الطبقات الكبرى ٣/٣٤٢ ذكر استخلاف عمر (رحمه الله)، نهاية الأرب في فنون الأدب ١٩/٢٤٠ ذكر قصّة الشورى، العقد الفريد ٤/٢٥٦ فرش كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم، أمر الشورى في خلافة عثمان بن عفان، وغيرها من المصادر الكثيرة جدّاً.
٢ - أنساب الأشراف ٦/١٢٨ أمر الشورى وبيعة عثمان (رضي الله عنه)، الإمامة والسياسة ١/٢٧ - ٢٨ ذكر الشورى وبيعة عثمان بن عفان (رضي الله عنه)، شرح نهج البلاغة ١/١٩٤، نهاية الأرب في فنون الأدب ١٩/٢٤٤ قصّة الشورى.
ونظيره في صحيح البخاري ٨/١٢٣ كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس، السنن الكبرى - للبيهقي ٨/١٤٧ كتاب قتال أهل البغي، باب كيفية البيعة، المصنف - لعبد الرزاق ٥/٤٧٧ كتاب المغازي، حديث أبي لؤلؤة قاتل عمر (رضي الله عنه)، وغيرها من المصادر الكثيرة.
ثمّ خرج وخرجوا معه حتى رقى المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: إنّ هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم، لا يُبَتّ(١) أمر دونهم، ولا يُقضى إلّا عن مشورتهم، وإنّهم قد رضوا وبايعوا ليزيد، فبايعوا على اسم الله.
فبايع الناس وكانوا يتربّصون بيعة هؤلاء النفر، ثمّ ركب رواحله وانصرف إلى المدينة(٢) .
فلقي الناس أولئك النفر فقالوا لهم: زعمتم أنّكم لا تبايعون، فلِمَ أُرضيتم وأُعطيتم وبايعتم؟ قالوا: والله ما فعلنا. فقالوا: ما منعكم أن تردّوا على الرجل؟ قالوا: كادنا وخفنا القتل(٣) .
كما إنّ ذلك هو المناسب لطلب مروان من الوليد بن عتبة أن يقتل الإمام الحسين (عليه السّلام) إن لم يبايع وتأنيبه له على ترك قتله(٤) ، ولعزل يزيد الوليد بن عتبة عن المدينة في شهر رمضان بعد خروج الإمام الحسين (عليه السّلام) بقليل(٥) ، بل صرّح في
____________________
١ - بتّ الأمر: أمضاه.
٢ - سمط النجوم العوالي ٣/٤٥.
٣ - الكامل في التاريخ ٣/٥٠٨ - ٥٠٩ أحداث سنة ست وخمسين من الهجرة: ذكر البيعة ليزيد بولاية العهد، واللفظ له، تاريخ خليفة بن خياط/١٦٤ أحداث سنة إحدى وخمسين من الهجرة، أخذ معاوية بن أبي سفيان البيعة لابنه يزيد، تاريخ الإسلام ٤/١٥٢ حوادث سنة إحدى وخمسين من الهجرة، الإمامة والسياسة ١/١٥٣ قدوم معاوية المدينة على هؤلاء القوم وما كان بينهم من المنازعة، سمط النجوم العوالي ٣/٤٥ عهد معاوية لابنه يزيد بالخلافة، وغيرها من المصادر.
٤ - تاريخ الطبري ٤/٢٥١ - ٢٥٢ أحداث سنة ستين من الهجرة، خلافة يزيد بن معاوية، الكامل في التاريخ ٤/١٥ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر بيعة يزيد، البداية والنهاية ٨/١٥٧ أحداث سنة ستين من الهجرة النبوية، يزيد بن معاوية وما جرى في أيامه، تاريخ الإسلام ٤/١٦٩ حوادث سنة ستين من الهجرة، بيعة يزيد، الفتوح - لابن أعثم ٥/١٤ ذكر الكتاب إلى أهل البيعة بأخذ البيعة، الإمامة والسياسة ١/١٦٥ إباية القوم الممتنعين عن البيعة، وغيرها من المصادر.
٥ - تاريخ ابن خلدون ٣/٢١ عزل الوليد عن المدينة وولاية عمرو بن سعيد، تاريخ الطبري ٤/٢٥٤ أحداث سنة ستين من الهجرة، خلافة يزيد بن معاوية، الكامل في التاريخ ٤/١٨ =
بعض المصادر أنّ سبب عزله امتناعه من تنفيذ أمر يزيد بإرغام الإمام الحسين (عليه السّلام) على البيعة(١) .
ولما ورد من أنّ أبا هرم رأى الإمام الحسين (صلوات الله عليه) وهو في طريقه إلى كربلاء فقال له: يابن النبي، ما الذي أخرجك من المدينة؟! فقال (عليه السّلام): «ويحك يا أبا هرم! شتموا عرضي فصبرت، وطلبوا مالي فصبرت، وطلبوا دمي فهربت. وأيم الله ليقتلنني...»(٢) .
الثالث: إنّ الإمام الحسين (صلوات الله عليه) لما دخل مكّة واجتمع الناس إليه بلغ يزيد ذلك فكتب إلى ابن عباس: أمّا بعد، فإنّ ابن عمّك حسيناً وعدوّ الله ابن الزبير التويا بيعتي، ولحقا بمكّة مرصدين للفتنة، معرضين أنفسهما للهلكة... وكتب أسفل الكتاب أبياتاً منها قوله:
إنّي لأعلمُ أو ظناً كعالمه |
والظنّ يصدق أحياناً فينتظمُ |
|
أن سوفَ يترككم ما تدعون به |
قتلى تهاداكم العقبانُ والرخمُ(٣) |
____________________
= أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر عزل الوليد عن المدينة وولاية عمر بن سعيد، البداية والنهاية ٨/١٥٨ أحداث سنة ستين من الهجرة النبوية، في ترجمة يزيد بن معاوية وما جرى في أيامه، وفي الاستيعاب ٣/١٣٨٨ في ترجمة مروان بن الحكم، وتاريخ دمشق ٦٣/٢٠٧ - ٢٠٨ في ترجمة الوليد بن عتبة بن صخر بن حرب، وتاريخ خليفة بن خياط/١٧٤ أحداث سنة ستين من الهجرة، إلّا إنّه لم يحدّد في شهر رمضان، وغيرها من المصادر.
١ - الاستيعاب ٣/١٣٨٨ في ترجمة مروان بن الحكم، البداية والنهاية ٨/١٥٨ أحداث سنة ستين من الهجرة، في ترجمة يزيد بن معاوية وما جرى في أيامه، مناقب آل أبي طالب - لابن شهرآشوب ٣/٢٤٠.
٢ - الأمالي - للصدوق/٢١٨ المجلس ٣٠، مثير الأحزان/٣٣، اللهوف في قتلى الطفوف/٤٣ - ٤٤، وقريب منه في الفتوح - لابن أعثم ٥/٧٩ ذكر مسير الحسين إلى العراق.
٣ - تذكرة الخواص/٢٣٧ - ٢٣٨ الباب التاسع في ذكر الحسين (عليه السّلام)، واللفظ له، وذكرت جميع الأبيات مع اختلاف في الكتاب في تاريخ دمشق ١٤/٢١١ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، وتهذيب الكمال ٦/٤٢٠ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، والبداية والنهاية ٨/١٧٧ في =
الرابع: ما روي من أنّ يزيد دسّ مع الحاج ثلاثين رجلاً من شياطين بني أُميّة وأمرهم باغتيال الإمام الحسين (عليه السّلام)(١) .
ويناسب ذلك حديث الفرزدق الشاعر قال: حججت بأُمّي، فأنا أسوق بعيرها حين دخلت الحرم في أيام الحجّ - وذلك في سنة ستين - إذ لقيت الحسين بن علي خارجاً من مكّة معه أسيافه وتراسه... فقلت: بأبي أنت وأُمّي يابن رسول الله، ما أعجلك عن الحجّ؟ فقال: «لو لم أعجل لأُخذت...»(٢) . وما سبق من أنّه (عليه السّلام) كان يعتذر عن خروجه بأنّه يخشى أن تُهتك به حرمة الحرم(٣) .
الخامس: بقاء ابن زياد عاملاً ليزيد حتى مات يزيد، بل قال ابن أعثم: لما قُتل الحسين استوسق العراقان جميعاً لعبيد الله بن زياد، وأوصله يزيد بألف ألف درهم جائزة...، ثمّ علا أمره، وارتفع قدره...(٤) .
وقال المسعودي: وكان يزيد صاحب طرب وجوارح وكلاب وقرود وفهود ومنادمة على الشراب، وجلس ذات يوم على شرابه وعن يمينه ابن زياد، وذلك بعد قتل الحسين، فأقبل على ساقيه وقال:
أسقني شربةً تروي مشاشي |
ثمّ مِل فاسقِ مثلها ابنَ زيادِ |
|
صاحبَ السرِّ والأمانةِ عندي |
ولتسديدِ مغنمي وجهادي(٥) |
____________________
= أحداث سنة ستين من الهجرة، صفة مخرج الحسين إلى العراق، وغيرها من المصادر.
١ - ينابيع المودّة ٣/٥٩ خروج الحسين من مكة، بحار الأنوار ٤٥/٩٩.
٢ - تاريخ الطبري ٤/٢٩٠ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مسير الحسين (عليه السّلام) من مكة متوجّهاً إلى الكوفة وما كان من أمره في مسيره، واللفظ له، البداية والنهاية ٨/١٨٠ أحداث سنة ستين من الهجرة، صفة مخرج الحسين إلى العراق، الأمالي - للشجري ١/١٦٦ فضل الحسين بن علي (عليهما السّلام) وذكر مصرعه وسائر أخباره وما يتصل بذلك.
٣ - تقدّمت مصادره في/٣٩.
٤ - الفتوح - لابن أعثم ٥/١٥٦ - ١٥٧ ذكر ما كان بعد مقتل الحسين بن علي (رضي الله عنهما).
٥ - مروج الذهب ٣/٧٨ فسق يزيد وعمّاله وزندقتهم.
السادس: طيش يزيد وعنجهيته حتى فعل بالمدينة المنوّرة في واقعة الحرّة، وفي مكّة المكرّمة في قتاله لابن الزبير ما فعل.
السابع: طلبه من ابن زياد إرسال العائلة الكريمة إلى الشام(١) ، فأرسلها بذلك الوضع المزري(٢) الذي أشارت إلى بعض مآسيه العقيلة زينب الكبرى بقولها في خطبتها في مجلس يزيد: أَمِنَ العدل يابن الطلقاء، تخديرك حرائرك وإمائك، وسوقك بنات رسول الله سبايا؟! قد هتكت ستورهنَّ، وأبديت وجوههنَّ، يحدي بهنَّ من بلد إلى بلد، ويستشرفهنَّ أهل المناهل والمناقل، ويتصفّح وجوههنَّ القريب والبعيد، والدني والشريف...!(٣) . ثمّ تزيين الشام لاستقبالهم(٤) ، وقد أُقيموا على درج باب المسجد حيث يُقام السبي(٥) ، وأُدخلوا على يزيد مربّقين بالحبال(٦) .
____________________
١ - الكامل في التاريخ ٤/٨٤ في أحداث سنة إحدى وستين، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، تاريخ الطبري ٤/٣٥٤ في أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ترجمة الإمام الحسين (عليه السّلام) من طبقات ابن سعد/٨١ ح ٢٩٦، اللهوف في قتلى الطفوف/٩٩، وغيرها من المصادر.
٢ - الفتوح - لابن أعثم ٥/١٤٧ ذكر كتاب عبيد الله بن زياد بن معاوية وبعثته إليه برأس الحسين بن علي (رضي الله عنهم)، الكامل في التاريخ ٤/٨٣ في أحداث سنة إحدى وستين، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، تاريخ الطبري ٤/٣٥٢ في أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، الثقات - لابن حبان ٢/٣١٢ - ٣١٣ في ترجمة يزيد بن معاوية، الفصول المهمّة ٢/٨٣١ الفصل الثالث، فصل في ذكر مصرعه ومدّة عمره وإمامته (عليه السّلام)، مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٥٥ - ٥٦، إقبال الأعمال ٣/٨٩، وغيرها من المصادر.
٣ - راجع ملحق رقم ٤.
٤ - مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٦٠.
٥ - الفتوح - لابن أعثم ٥/١٤٩ ذكر كتاب عبيد الله بن زياد بن معاوية وبعثته إليه برأس الحسين بن علي (رضي الله عنهم)، مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٦١، الأمالي - للصدوق/٢٣٠، اللهوف في قتلى الطفوف/١٠٢، الاحتجاج ٢/٣٣، البدء والتاريخ ٦/١٢ مقتل أبي عبد الله الحسين بن علي (رضي الله عنهم).
تاريخ مختصر الدول/١١٠ - ١١١ الدولة التاسعة، يزيد بن معاوية، وغيرها من المصادر.
٦ - ترجمة الإمام الحسين (عليه السّلام) من طبقات ابن سعد/٨٣ ح ٢٩٧، الكامل في التاريخ ٤/٨٦ في =
الثامن: صلب رأس الإمام الحسين (عليه السّلام)(١) على باب القصر في دمشق ثلاثة أيام(٢) ، ثمّ التشهير به وتسييره في البلدان(٣) .
التاسع: إظهار السرور والشماتة بقتل الإمام الحسين (عليه السّلام)(٤) ، وإنشاده الأبيات السابقة، وقوله: إنّ هذا وإيّانا كما قال الحصين بن الحمام:
أبى قومنا أن ينصفونا فأنصفت |
قواضبُ في أيماننا تقطرُ الدما |
|
يُفلّقنَ هاماً من رجالٍ أعزة |
علينا وهم كانوا أعقَّ وأظلما(٥) |
____________________
= أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، أنساب الأشراف ٣/٤١٦ مقتل الحسين بن علي (عليهما السّلام)، العقد الفريد ٤/٣٥٠ فرش كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم، مقتل الحسين بن علي، تذكرة الخواص/٢٦٢، الإمامة والسياسة ٢/١٨٥ قدوم من أسر من آل علي على يزيد، وغيرها من المصادر.
١ - تاريخ دمشق ١٦/١٨٠ في ترجمة خالد بن غفران، السيرة الحلبية ٣/١٥٧ في كلامه عن سرية أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد، مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٧٣ - ٧٤، الأمالي - للصدوق/٢٣١ المجلس الحادي والثلاثون، وغيرها من المصادر.
٢ - مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٧٥، تاريخ دمشق ٦٩/١٦٠ في ترجمة ريا حاضنة يزيد بن معاوية، سير أعلام النبلاء ٣/٣١٩ في ترجمة الحسين الشهيد، تاريخ الإسلام ٥/١٠٧ في ترجمة الحسين بن علي (رضي الله عنه)، الوافي بالوفيات ١٢/٢٦٤، البداية والنهاية ٨/٢٢٢ في أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، صفة مقتله مأخوذة من أئمّة الشأن، وغيرها من المصادر.
٣ - أنساب الأشراف ٣/٤١٩ في مقتل الحسين بن علي (عليهما السّلام)، نور الأبصار/١٤٧ فصل اختلفوا في رأس الحسين (رضي الله عنه)، مثير الأحزان/٨٥.
٤ - الثقات - لابن حبان ٢/٣١٣ في ترجمة يزيد بن معاوية، سير أعلام النبلاء ٣/٣٢٠ في ترجمة الحسين الشهيد، البداية والنهاية ٨/٢٠٩ - ٢١١ في أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، صفة مقتله مأخوذة من كلام أئمّة الشأن، الأنساب - للسمعاني ٣/٤٧٦ في كلامه عن الشهيد، أنساب الأشراف ٣/٤١٦ مقتل الحسين بن علي (عليهما السّلام)، وغيرها من المصادر.
٥ - الكامل في التاريخ ٤/٨٥ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، واللفظ له، الفصول المهمّة ٢/٨٣٤، وقد اقتصر على البيت الثاني في مجمع الزوائد ٩/١٩٣ كتاب المناقب، باب مناقب الحسين بن علي (عليهما السّلام)، والمعجم الكبير ٣/١٠٤ مسند الحسين بن علي، ذكر مولده وصفته، وتاريخ دمشق ٦٢/٨٥ في ترجمة نضلة بن عبيد، و٦٥/٣٩٦ في ترجمة يزيد بن معاوية، و٦٨/٩٥ في ترجمة رجل من خثعم له صحبة، و٧٠/١٤ - ١٥ في ترجمة فاطمة =
العاشر: ردّ العقيلة زينب الكبرى على يزيد في خطبتها المشار إليها آنفاً، وكتاب ابن عباس له(١) المؤكّد لاشتراكه في الجريمة... إلى غير ذلك ممّا لا يبقى معه شك في أمر يزيد بقتل الإمام الحسين (عليه السّلام) وسروره به بعد حصوله.
محاولة يزيد التنصّل من الجريمة واستنكاره لها
ومع كلّ ذلك فقد تبدّل موقف يزيد حيث نسب له بعض المؤرّخين وأهل الحديث التنصّل من الجريمة، أو الاستنكار لها، وأنّه كان يرضى من طاعة أهل الكوفة بدون ذلك، وأنّه قد حمّل ابن زياد مسؤوليتها(٢) .
وروى غير واحد أنّه قد أُقيم المأتم على الإمام الحسين (صلوات الله عليه) في داره، وشاركت عائلته عائلة الإمام الحسين (عليه السّلام) فيه(٣) .
____________________
= بنت الحسين بن علي بن أبي طالب، وأسد الغابة ٥/٣٨١ في ترجمة عبد الواحد بن عبد الله القرشي، وتهذيب الكمال ٦/٤٢٨ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، وغيرها من المصادر الكثيرة جدّاً.
١ - المعجم الكبير ١٠/٢٤٢ أحاديث عبد الله بن عباس، ومن مناقب عبد الله بن عباس وأخباره، مجمع الزوائد ٧/٢٥١ كتاب الفتن، باب فيما كان من أمر ابن الزبير، الكامل في التاريخ ٤/١٢٨ في أحداث سنة أربع وستين من الهجرة، ذكر بعض سيرة يزيد وأخباره، تاريخ اليعقوبي ٢/٢٤٨ في مقتل الحسين بن علي، مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٧٨، وغيرها من المصادر.
٢ - الكامل في التاريخ ٤/٨٤ - ٨٥، ٨٧ في أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، تاريخ الطبري ٤/٣٥٢ في أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، الفتوح - لابن أعثم ٥/١٤٨ ذكر كتاب عبيد الله بن زياد بن معاوية وبعثته إليه برأس الحسين بن علي (رضي الله عنهما)، تاريخ دمشق ١٨/٤٤٥ في ترجمة زحر بن قيس الجعفي، أنساب الأشراف ٣/٤١٥ مقتل الحسين بن علي (عليهما السّلام)، الأخبار الطوال/٢٦١ نهاية الحسين، ترجمة الإمام الحسين (عليه السّلام) من طبقات ابن سعد/٨٣ ح ٢٩٧، مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٥٦، وغيرها من المصادر الكثيرة.
٣ - تاريخ الطبري ٤/٣٥٥ في أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، البداية والنهاية ٨/٢١٢ في أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، صفة مقتله مأخوذة من كلام أئمّة الشأن، أنساب الأشراف ٣/٤١٧ مقتل الحسين بن علي (عليهما السّلام)، سير أعلام النبلاء ٣/٣٠٤ في ترجمة الحسين الشهيد، تذكرة الخواص/٢٦٥، الأمالي - للصدوق/٢٣٠، وغيرها من المصادر.
بل لا إشكال في أنّه أسرع بإرجاع العائلة الثاكلة للمدينة المنوّرة مكرّمة معزّزة، وفسح المجال لها لإقامة المآتم ومراسم العزاء بوجه مهيج للشعور ضدّه على الصعيد العام، وغضّ النظر عن تبعة ذلك عليه.
كما إنّه أوصى مسلم بن عقبة صاحب وقعة الحرّة بالإمام زين العابدين (صلوات الله عليه)(١) ، وأعفاه من البيعة التي طلبها من أهل المدينة(٢) حيث طلب منهم أن يبايعوا على أنّهم عبيد ليزيد(٣) .
____________________
١ - سير أعلام النبلاء ٣/٣٢٠ - ٣٢١ في ترجمة الحسين الشهيد، تاريخ الإسلام ٥/٢١ الطبقة السابعة، حوادث سنة واحد وستين من الهجرة، مقتل الحسين/٢٨ قصّة الحرّة، تاريخ الطبري ٤/٣٧٩ أحداث سنة ثلاث وستين من الهجرة، البداية والنهاية ٨/٢٣٩ - ٢٤١ أحداث سنة ثلاث وستين من الهجرة عن الحديث عن وقعة الحرّة، الفتوح - لابن أعثم ٥/١٨٤ ذكر حرّة واقم وما قُتل فيها من المسلمين، الكامل في التاريخ ٤/١١٩ - ١٢٠ أحداث سنة ثلاث وستين من الهجرة، ذكر وقعة الحرّة، وغيرها من المصادر.
٢ - تاريخ الطبري ٤/٣٧٩ أحداث سنة ثلاث وستين من الهجرة، تاريخ الإسلام ٥/٢٨ الطبقة السابعة، حوادث سنة واحد وستين من الهجرة، قصّة الحرّة، الفتوح - لابن أعثم ٥/١٨٤ ذكر حرّة واقم وما قُتل فيها من المسلمين، الكامل في التاريخ ٤/١١١ - ١١٢ أحداث سنة ثلاث وستين من الهجرة، ذكر وقعة الحرّة، تاريخ اليعقوبي ٢/٢٥١ في مقتل الحسين بن علي، مروج الذهب ٣/٨٠ - ٨١ معركة حرّة واقم، وغيرها من المصادر.
٣ - الإصابة ٦/٢٣٢ في ترجمة مسلم بن عقبة بن رباح، تهذيب التهذيب ١١/٣١٦ في ترجمة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، فتح الباري ١٣/٦٠ - ٦١، تاريخ الطبري ٤/٣٧٩ - ٣٨١ أحداث سنة ثلاث وستين من الهجرة، الكامل في التاريخ ٤/١١٨ أحداث سنة ثلاث وستين من الهجرة، ذكر وقعة الحرّة، تاريخ الإسلام ٥/٢٩ - ٣٠ الطبقة السابعة، حوادث سنة واحد وستين من الهجرة، قصّة الحرّة، البداية والنهاية ٨/٢٤٣ أحداث ستة ثلاث وستين من الهجرة، الإمامة والسياسة ٢/١٨٧ إخراج بني أُميّة عن المدينة وذكر قتال أهل الحرّة، تاريخ خليفة بن خياط/١٨٣ أحداث سنة ثلاث وستين من الهجرة، أمر الحرّة، تاريخ دمشق ٥٨/١٠٥ - ١٠٧، ١١٤ في ترجمة مسلم بن عقبة، لسان الميزان ٦/٢٩٣ في ترجمة يزيد بن معاوية، الفتوح - لابن أعثم ٥/١٨٢ ذكر حرّة واقم وما قُتل فيها من المسلمين، تاريخ اليعقوبي ٢/٢٥٠ في مقتل الحسين بن علي، النصائح الكافية/٦٢، معجم البلدان ٢/٢٤٩ في (حرّة واقم)، وغيرها من المصادر الكثيرة.
وكلّ ذلك لا بدّ أن يكون بسبب ردود الفعل المباشرة التي سبق الكلام فيها، والتي تكشف عن شدّة وقع الجريمة في نفوس المسلمين حيث شعر بخسارته في المعركة شعوراً فرض عليه الخروج في معالجة الموقف عن طبيعته في الطيش والعنجهية التي بقيت معه في بقيّة الأحداث التي واجهته بعد فاجعة الطفّ، ومنها ردّه ببشاعة على أهل المدينة في واقعة الحرّة، وعلى ابن الزبير في استحلال الحرم، ورمي مكّة المكرّمة والكعبة المعظّمة بالمنجنيق.
قال ابن الأثير: وقيل: ولما وصل رأس الحسين إلى يزيد حسُنت حال ابن زياد عنده، ووصله وسرّه ما فعل، ثمّ لم يلبث إلّا يسيراً حتى بلغه بغض الناس له، ولعنهم وسبّهم؛ فندم على قتل الحسين، فكان يقول: وما عليّ لو احتملت الأذى وأنزلت الحسين معي في داري، وحكمته فيما يريد، وإن كان عليّ في ذلك وهن في سلطاني... لعن الله ابن مرجانة فإنّه اضطره... فقتله، فبغّضني بقتله إلى المسلمين، وزرع في قلوبهم العداوة، فأبغضني البرّ والفاجر بما استعظموه من قتلي الحسين. ما لي ولابن مرجانة، لعنه الله، وغضب عليه؟!(١) .
وقد روى مثل ذلك الطبري وغيره عن أبي عبيدة عن يونس بن حبيب(٢) .
محاولة ابن زياد التنصّل من الجريمة وشعوره بالخطأ
كما يظهر أنّ ابن زياد أيضاً حاول أن يتنصّل من قتل الإمام الحسين (عليه السّلام)، ويُحمّل عمر بن سعد تبعته. قال الطبري: قال هشام: عن عوانة، قال: قال عبيد الله بن زياد لعمر بن سعد بعد قتله الحسين: يا عمر، أين الكتاب الذي كتبت إليك في قتل الحسين؟ قال: مضيت لأمرك، وضاع الكتاب. قال: لتجيئن به. قال:
____________________
١ - الكامل في التاريخ ٤/٨٧ في أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه).
٢ - تاريخ الطبري ٤/٣٨٨، ذكر الخبر عمّا كان من أمر عبيد الله بن زياد وأمر أهل البصرة معه بها بعد موت يزيد، سير أعلام النبلاء ٣/٣١٧ في ترجمة الحسين الشهيد.
ضاع. قال: والله لتجيئني به. قال: تُرك والله يُقرأ على عجائز قريش؛ اعتذاراً إليهنَّ بالمدينة. أما والله، لقد نصحتك في حسين نصيحة لو نصحتها أبي سعد بن أبي وقّاص كنت قد أدّيت حقّه. قال عثمان بن زياد أخو عبيد الله: صدق والله. والله، لوددت أنّه ليس من بني زياد رجل إلّا وفي أنفه خزامة إلى يوم القيامة وأن حسيناً لم يُقتل. قال: فوالله، ما أنكر ذلك عليه عبيد الله(١) . وقد ذكر ابن الأثير أيضاً حديث عبيد الله بن زياد هذا مع عمر بن سعد من دون أن يذكر السند(٢) .
وقالت مرجانة لابنها عبيد الله بن زياد: يا خبيث! قتلت ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! لا ترى الجنّة أبداً(٣) .
ويبدو شعور يزيد وابن زياد بسوء تبعة قتل الإمام الحسين (عليه السّلام) عليهما ممّا رواه ابن أعثم من أنّ يزيد حين علم إصرار ابن الزبير على الامتناع من بيعته أمهله، وأخذ يتأنّى في أمره، ويقول لأصحابه: ويحكم! إنّي قتلت بالأمس الحسين بن علي وأقتل اليوم عبد الله بن الزبير؟! أخاف أن تشعث عليّ العامّة، ولا يحتمل ذلك لي، ويتنغّص عليّ أمري(٤) .
____________________
١ - تاريخ الطبري ٤/٣٥٧ في أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، عند الكلام في مقتل الحسين (عليه السّلام)، واللفظ له، ومثله في البداية والنهاية ٨/٢٢٧ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، فصل [بلا عنوان].
٢ - الكامل في التاريخ ٤/٩٣ - ٩٤ في أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه).
٣ - تاريخ دمشق ٣٧/٤٥١ في ترجمة عبيد الله بن زياد، واللفظ له. الكامل في التاريخ ٤/٢٦٥ أحداث سنة سبع وستين من الهجرة، ذكر مقتل ابن زياد، تهذيب التهذيب ٢/٣٠٨ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، تاريخ الإسلام ٥/١٥ الطبقة السابعة، حوادث سنة واحد وستين من الهجرة، مقتل الحسين، البداية والنهاية ٨/٣١٤ أحداث سنة سبع وستين من الهجرة، ترجمة ابن زياد، الوافي بالوفيات ١٢/٢٦٥، ترجمة الإمام الحسين (عليه السّلام) من طبقات ابن سعد/٨٨ ح ٣١١، وغيرها من المصادر.
٤ - الفتوح - لابن أعثم ٥/١٧٤ ابتداء حرب واقم وما قُتل فيها من أولاد المهاجرين والأنصار والعبيد والموالي.
وممّا ذكره غير واحد من أنّ يزيد لما كتب إلى ابن زياد يأمره بغزو ابن الزبير، قال ابن زياد: لا أجمعهما للفاسق أبداً. أقتل ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأغزو البيت؟!(١) .
موقف الحكّام إذا أدركوا سوء عاقبة جرائمهم عليهم
وهذه هي الطريقة التي يجري عليها الحكّام عموماً عندما يشعرون بخطأ مواقفهم، أو يرون ردود فعلها السيئة عليهم؛ حيث يحاولون أن يتنصّلوا منه، ويحمّلوا عمّالهم وأعوانهم تبعتها.
وربما أبعدوهم وعزلوهم، بل قد يعاقبونهم أو يقيدون منهم ويقتصّون؛ إمعاناً في التنصّل ممّا قاموا به.
لكنّ الذي يبدو أنّ شكر يزيد في نفسه لابن زياد على جريمته، وامتنانه منه، جعله يتريّث في ذلك؛ حيث لم يظهر منه تبدّل في موقفه من ابن زياد حتى مات.
موقف معاوية ممّا فعله بسر بن أرطاة
وبالمناسبة ذكر ابن أبي الحديد ما فعله بسر بن أرطاة في غارته بأمر معاوية على الحرمين وبلاد الحجاز عامّة ونجد واليمن، وقتله ابني عبيد الله بن العباس وهما صبيان، ثمّ قال:
وروى أبو الحسن المدائني قال: اجتمع عبيد الله بن العباس وبسر بن أرطاة يوماً عند معاوية بعد صلح الحسن (عليه السّلام)، فقال له ابن عباس: أنت أمرت
____________________
١ - تاريخ الطبري ٤/٣٧١ في أحداث سنة ثلاث وستين من الهجرة، واللفظ له، البداية والنهاية ٨/٢٣٩ أحداث سنة ثلاث وستين من الهجرة عن الحديث عن وقعة الحرّة، الكامل في التاريخ ٤/١١١ - ١١٢ أحداث سنة ثلاث وستين من الهجرة، ذكر وقعة الحرّة، وقريب منه في الأمالي - للشجري ١/١٦٤ الحديث الثامن، فضل الحسين بن علي (عليهما السّلام) وذكر مصرعه وسائر أخباره وما يتصل بذلك.
اللعين السيء الفدْم(١) أن يقتل ابني؟ فقال: ما أمرته بذلك. ولوددت أنّه لم يكن قتلهم. فغضب بسر، ونزع سيفه فألقاه، وقال لمعاوية: اقبض سيفك؛ قلدتنيه وأمرتني أن أخبط به الناس ففعلت، حتى إذا بلغت ما أردت قلت: لم أهوَ ولم آمر؟! فقال: خذ سيفك، فلعمري، إنّك ضعيف مائق حين تُلقي السيف بين يدي رجل من بني عبد مناف قد قتلت أمس ابنيه. فقال له عبيد الله بن العباس: أتحسبني يا معاوية قاتلاً بسراً بأحد ابني؟! هو أحقر وألأم من ذلك، ولكنّي والله لا أرى لي مقنعاً ولا أدرك ثأراً إلّا أن أُصيب بهما يزيد وعبد الله. فتبسّم معاوية وقال: وما ذنب معاوية وابني معاوية؟! والله، ما علمت ولا أمرت، ولا رضيت ولا هويت، واحتملها منه لشرفه وسؤدده(٢) .
وقد جرى الخلف على سنن السلف، كما قال الشاعر:
نبني كما كانت أوائلنا |
تبني ونفعلُ مثلَ ما فعلوا |
وعلى كلّ حال فالذي يظهر بعد ملاحظة الأحداث والتدبّر فيها أنّ الجريمة بأبعادها الواقعية والعاطفية قد أخذت موقعها في نفوس المسلمين، وصارت صرخة في ضمائرهم تُرعب الظالمين.
وإلاّ فمن غير الطبيعي أن يتراجع هذان الجبّاران المستهتران مع ما هما عليه من الطيش والعنجهية بهذه السرعة من دون أن يظهر أي وهن في قواهما المادية، أو التخلّي منهما عن سياسة العنف والعنجهية في معالجة المشاكل الطارئة.
وقد صدق مَنْ قال: ما رأيتُ واقعةً كواقعةِ الطفّ عضّ فيها المنتصرُ
____________________
١ - قال في لسان العرب: الفدم من الناس: العيي عن الحجة والكلام، مع ثقل ورخاوة وقلّة فهم. وهو أيضاً الغليظ السمين الأحمق الجافي.
٢ - شرح نهج البلاغة ٢/١٧ - ١٨، وقريب منه في أنساب الأشراف ٣/٢١٦ غارة بسر بن أرطاة القرشي.
أناملهُ ندماً.
ويبدو أنّ مقام أهل البيت (صلوات الله عليهم)، وفداحة مصيبتهم وآثارها السلبية على أعدائهم قد فرض نفسه على أرض الواقع حتى اضطر للاعتراف به أعداؤهم.
موقف عبد الملك بن مروان من الفاجعة
فمروان بن الحكم من ألدّ أعدائهم حتى إنّه كان من المحرّضين على قتل الإمام الحسين (صلوات الله عليه)(١) ، وأظهر الشماتة بقتله.حتى إنه قال حينما رأى رأس الإمام الحسين (عليه السلام):
ضرب الدوسر فيهم ضربة |
أثبتت أوتاد ملك فاستقر |
وقال:
يا حبذا بردك في اليدين |
ولونك الأحمر في الخدين(٢) |
لكن ابنه عبد الملك كتب إلى الحجاج حينما كان عاملاً له على الحجاز: «جنبني دماء آل بني أبي طالب. فإني رأيت بني حرب لما قتلوا الحسين نزع الله ملكهم»(٣) .
____________________
١- تقدمت مصادره ص: ١٢٢.
٢ - تذكرة الخواص ص: ٢٦٦ الباب التاسع في ذكر حمل الرأس إلى يزيد: ذكر الحسين (عليه السلام).
١ - المحاسن والمساوئ - للبيهقي/٤٠ مساوئ من عادى علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، واللفظ له، أنساب الأشراف ٧/٢٣٣ ما قيل في عبد الملك وأخباره بعد مقتل ابن الزبير، مروج الذهب ٣/١٧٦ ذكر أيام الوليد بن عبد الملك في رسالة أخرى من عبد الملك إلى الحجّاج، العقد الفريد ٤/٣٥٢ فرش كتاب العسجدة الثانية، تسمية مَنْ قُتل مع الحسين بن علي (رضي الله عنهما) من أهل بيته ومَنْ أُسر منهم/٣٦٦ ولاية عبد الملك بن مروان، الفصول المهمّة ٢/٨٦٣ الفصل الرابع في ذكر علي بن الحسين (عليهما السّلام)، ينابيع المودّة ٣/١٠٧، ترجمة الإمام الحسين (عليه السّلام) من طبقات ابن سعد/٩٢ ح ٣٢٩، سبل الهدى والرشاد ١١/٧٨، تاريخ اليعقوبي ٢/٣٠٤ وفاة علي بن =
مع وضوح أنّ يزيد لم يقتصر على واقعة الطفّ، بل أعقبها بواقعة الحرّة بفظاعتها وبشاعتها، وبهتك حرمة الحرم ورمي الكعبة المعظّمة بالمنجنيق؛ فنسبة عبد الملك انخذال بني حرب لخصوص واقعة الطفّ شاهد بما ذكرنا.
إدراك الوليد بن عتبة سوء أثر الجريمة على الأمويين
بل يظهر أن الوليد بن عتبة بن أبي سفيان قد أدرك ذلك من أوّل الأمر، فهو لم يستجب ليزيد حينما أمره بقتل الإمام الحسين (عليه السّلام) إن لم يبايع. ولما عتب عليه مروان بن الحكم في ذلك لم يعتبه، بل أصرّ على موقفه، وقد بادر يزيد فعزله عن ولاية المدينة المنوّرة كما سبق(١) .
ولمّا سار الحسين (عليه السّلام) إلى الكوفة كتب الوليد إلى ابن زياد: أمّا بعد، فإنّ الحسين بن علي قد توجّه إلى العراق، وهو ابن فاطمة، وفاطمة بنت رسول الله، فاحذر يابن زياد أن تأتي إليه بسوء، فتهيج على نفسك وقومك في هذه الدنيا ما لا يسدّه شيء، ولا تنساه الخاصّة والعامّة أبداً مادامت الدنيا(٢) .
وربما نُسب هذا الكتاب لمروان بن الحكم(٣) ، لكنّ نفسية مروان ومواقفه قبل قتل الإمام الحسين (صلوات الله عليه) وبعده لا تناسب ذلك.
وكيف كان فالكتاب المذكور يكشف عن إدراك كاتبه مسبقاً لشدّة بشاعة
____________________
= الحسين، جواهر المطالب ٢/٢٧٨ الباب الخامس والسبعون، تسمية مَنْ قتل مع الحسين (عليه السّلام) وأهل بيته ومَنْ أُسر منهم.
١ - تقدّمت مصادره في/١٢٠ - ١٢١.
٢ - بحار الأنوار ٤٤/٣٦٨، واللفظ له، مقتل الحسين - للخوارزمي ١/٢٢١ الفصل الحادي عشر، الفتوح - لابن أعثم ٥/٧٨ ذكر مسير الحسين إلى العراق، إلّا أنّ فيه بدل (أن تأتي إليه بسوء فتهيج) (أن تبعث إليه رسولاً فتفتح).
٣ - تاريخ دمشق ١٤/٢١٢ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، تهذيب الكمال ٦/٤٢٢ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، ترجمة الإمام الحسين من طبقات ابن سعد/٦٢ ح ٢٨٣.
الجريمة وأثرها السلبي على السلطة الغاشمة وبني أُميّة عامّة.
موقف معاوية المسبق من الجريمة
ولعلّ ذلك هو الذي دعا معاوية إلى أن يوصي يزيد بالإمام الحسين (عليه السّلام) فيما رواه جماعة(١) . ففي رواية الطبري أنّه قال له: وأمّا الحسين بن علي فإنّ أهل العراق لن يدعوه حتى يخرجوه، فإن خرج عليك فظفرت به فاصفح عنه؛ فإنّ له رحماً ماسّة، وحقّاً عظيماً(٢) .
وإلاّ فمعاوية قد قتل الإمام الحسن (صلوات الله عليه) بالسمّ(٣) ، وشمت بموته(٤) ، مع أنّ الإمام الحسن (عليه السّلام) يشارك الإمام الحسين (عليه السّلام) في الرحم والحقّ،
____________________
١ - الكامل في التاريخ ٤/٦ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر وفاة معاوية بن أبي سفيان، البداية والنهاية ٨/١٢٣ في أحداث سنة ستين من الهجرة النبويّة، تاريخ ابن خلدون ٣/١٨ وفاة معاوية، الأخبار الطوال/٢٢٦ موت معاوية، وغيرها من المصادر.
٢ - تاريخ الطبري ٤/٢٣٨ في أحداث سنة ستين من الهجرة.
٣ - الاستيعاب ١/٣٨٩ - ٣٩٠ في ترجمة الحسن بن علي بن أبي طالب، تاريخ دمشق ١٣/٢٨٤ في ترجمة الحسن بن علي بن أبي طالب، تهذيب الكمال ٦/٢٥٢ في ترجمة الحسن بن علي بن أبي طالب، سير أعلام النبلاء ٣/٢٧٤ في ترجمة الحسن بن علي بن أبي طالب، البداية والنهاية ٨/٤٧ في أحداث سنة تسع وأربعين من الهجرة، في ذكر الحسن بن علي بن أبي طالب، مقتل الحسين - للخوارزمي ١/١٣٦ الفصل السادس، تذكرة الخواص/٢١١ الباب الثامن في ذكر الحسن (عليه السّلام)، ذكر وفاته (عليه السّلام)، شرح نهج البلاغة ١٦/١١، عيون الأنباء في طبقات الأطباء/١٧٤، الإرشاد ٢/١٦، مناقب آل أبي طالب - لابن شهرآشوب ٣/٢٠٢، وغيرها من المصادر.
٤ - الإمامة والسياسة ١/١٤٢ موت الحسن بن علي (رضي الله عنهما)، العقد الفريد ٤/٣٣١ فرش كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم، خلافة الحسن بن علي، مقتل الحسين - للخوارزمي ١/١٤٠ الفصل السادس، تاريخ الخميس ٢/٢٩٤ ذكر وصية الحسن لأخيه الحسين (رضي الله عنهما)، وفيات الأعيان ٢/٦٦ - ٦٧ في ترجمة الحسن بن علي بن أبي طالب، مروج الذهب ٣/٩ أثر موت الحسن (رضي الله عنه) على معاوية، تذكرة الخواص/٢١٤ الباب الثامن في ذكر الحسن (عليه السّلام)، ذكر وفاته (عليه السّلام)، حياة الحيوان/١٠٨ في (الأوز)، الأمالي - للمرتضى ١/٢٠٠ المجلس التاسع عشر، مناقب آل =
إن لم يزد عليه في معايير الحقّ عندهم.
على أنّ ابن عساكر روى ما يناسب إقرار معاوية ليزيد فيما حصل منه مع الإمام الحسين (عليه السّلام)، حيث ذكر أنّه قال له: انظر حسين بن علي بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فإنّه أحبّ الناس إلى الناس، فصل رحمه، وارفق به يصلح لك أمره، فإنّ يك منه شيء فإنّي أرجو أن يكفيكه الله بمَنْ قتل أباه، وخذل أخاه(١) .
إذ من الظاهر أنّ أهل الكوفة لا يكفونه أمر الإمام الحسين (صلوات الله عليه) إذا لم يأمرهم يزيد بذلك، ويستعين على تحقيقه بالترغيب والترهيب، فلو لم يكن معاوية راضياً به لم يكتفِ بتنبيه يزيد لموقفهم.
ويشبه ذلك ما رواه بعضهم في موقفه من أهل المدينة المنوّرة حيث ورد أنّه قال ليزيد: إنّ لك من أهل المدينة يوم، فإن فعلوا فارمهم بمسلم بن عقبة؛ فإنّه رجل قد عرفت نصيحته(٢) .
____________________
= أبي طالب - لابن شهرآشوب ٣/٢٠٣، وغيرها من المصادر.
١ - تاريخ دمشق ١٤/٢٠٦ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، واللفظ له، تهذيب الكمال ٦/٤١٤ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، تاريخ الإسلام ٥/٧ الطبقة السابعة، حوادث سنة واحد وستين من الهجرة، مقتل الحسين، البداية والنهاية ٨/١٧٥ أحداث سنة ستين من الهجرة، صفة مخرج الحسين إلى العراق، ترجمة الإمام الحسين (عليه السّلام) من طبقات ابن سعد/٥٥ ح ٢٨٣، وغيرها من المصادر.
٢ - تاريخ الطبري ٤/٣٨٠ أحداث سنة ثلاث وستين من الهجرة، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/١١٢ أحداث سنة ثلاث وستين من الهجرة، ذكر وقعة الحرّة، البداية والنهاية ٨/٢٤٢ أحداث سنة ثلاث وستين من الهجرة، تاريخ خليفة بن خياط/١٨٢ أحداث سنة ثلاث وستين من الهجرة، أمر الحرّة، تاريخ دمشق ٥٨/١٠٤ في ترجمة مسلم بن عقبة بن رياح، فتح الباري ١٣/٦٠، وغيرها من المصادر.
المقصد الثاني
في ثمرات فاجعة الطفّ وفوائدها
والكلام.. تارة: فيما جناه دين الإسلام العظيم من ثمرات النهضة المباركة التي انتهت بالفاجعة.
وأُخرى: في العِبَر التي تستخلص من هذه النهضة الشريفة؛ لينتفع بها المعتبرون، ولاسيما الذين يهتمّون بالصالح العام.
وذلك في فصلين:
الفصل الأوّل
فيما جناه الدين من ثمرات فاجعة الطفّ
وهذا هو المنظور الأوّل للإمام الحسين (صلوات الله عليه)، وهو الذي يرتفع به إلى منزلة القدّيسين، وبه صار ثار الله (عزّ وجلّ)(١) .
الهدف الأوّل للإمام الحسين (عليه السّلام)
فإنّه (صلوات الله عليه) مهما تمتّع به من مؤهّلات ومثالية هي مدعاة للفخر والاعتزاز، ودليل على سموّ الذات - كإباء الضيم، وقوّة الإرادة، ووحدة
____________________
١ - تقدّمت مصادره في/٩١.
الموقف، والشجاعة، والصبر، والسخاء، والشرف، وغير ذلك - فهو فوق كلّ ذلك عبد لله (عزّ وجلّ)، فانٍ في ذاته تعالى، وصاحب رسالة قد حمّله الله سبحانه إيّاه، وائتمنه عليها.
وقد تحمّل (عليه السّلام) مسؤولية حفظها ورعايتها وخدمتها، فيلزمه النظر فيما يصلحها، وبذل كلّ إمكانيّاته ومؤهّلاته في سبيل ذلك، ولها الأولوية عنده على كلّ شيء.
ولذا نرى ذلك الشخص الأبي، والذي وقف من يزيد ذلك الموقف الصلب - مع علمه بأنّه يؤدّي إلى تلك التضحيات الجسيمة - قد صبر عشرين عاماً على مضض، ولم يحرّك ساكناً مع معاوية مع إنّه قد نقض العهد، وتجاوز الحدود، وانتهك حرمته (عليه السّلام)، وحرمة أهل بيته وشيعته، وحرمة الدين الذي كان (صلوات الله عليه) مسؤولاً عنه وعن رعايته.
كلّ ذلك لأنّ مصلحة دين الإسلام العظيم الذي كان الإمام الحسين (صلوات الله عليه) مسؤولاً عنه قد فرضت عليه في كلّ ظرف الموقف المناسب له مهما كلّفه من متاعب ومصائب ومآسٍ وفجائع.
فنحن نقدّس الإمام الحسين (صلوات الله عليه)، ونشيد بموقفه في حفظ الدين قبل أن نشيد بإبائه للضيم وشجاعته، وصبره وصلابة موقفه وتضحيته الكبرى نتيجة ذلك، بل لا نشيد بهذه الأمور منه (عليه السّلام) إلّا من أجل أنّها صارت وسيلة لخدمة قضيته، وأداء منه لأمانته إزاء الدين التي تحمّلها (عليه السّلام) بإخلاص.
وهكذا الحال في جميع الأئمّة من أهل البيت (صلوات الله عليهم) وإن اختلفت المواقف تبعاً لاختلاف الظروف، فمواقفهم جميعاً (صلوات الله عليهم) ليست كيفية، ولا مزاجية، ولا انفعالية، بل هي مواقف حكيمة - بتسديد من الله (عزّ وجلّ) - لخدمة القضية الكبرى، وقياماً بمقتضى الأمانة التي حُمّلوها
إزاء الدين، قد يظهر لنا وجه الحكمة في بعضه، وقد يخفى علينا في بعضه.
ونعود للحديث عمّا كسبه الدين الحنيف من نهضة الإمام الحسين (صلوات الله عليه)، فنقول:
بعدما سبق من أنّ نهضة الإمام الحسين (صلوات الله عليه) كانت بأمر من الله تعالى، وبتسديد منه، فلا بدّ أن يكون الهدف منها مصلحة للدين - الذي هو أهم شيء عند الله (عزّ وجلّ) - تناسب حجم التضحية.
ومن ثمّ كان ذلك هو المتسالم عليه عند شيعة أهل البيت (أعز الله دعوتهم) حتى قال شاعرهم بعد أن تعرّض لتحلّل يزيد واستهتاره:
وأصبحَ الدينُ منه يشتكي سقما |
وما إلى أحدٍ غيرَ الحسينِ شكا |
|
فما رأى السبطُ للدينِ الحنيفِ شفا |
إلّا إذا دمهُ في نصرهِ سفكا |
|
وما رأينا عليلاً لا شفاءَ له |
إلّا بنفسِ مداويه إذا هلكا |
|
بقتلهِ فاحَ للإسلامِ نشرُ هدى |
فكلّما ذكرتهُ المسلمونَ ذكى |
وقد تضمّنت زياراته (صلوات الله عليه)، وزيارات أصحابه (عليهم السّلام) معه التي وردت عن الأئمّة (صلوات الله عليهم) ما يناسب ذلك، حيث تكرّر فيها التعبير بأنّهم أنصار الله (عزّ وجلّ) وأنصار دينه ورسوله، ووضوح ذلك يُغني عن إطالة الكلام فيه.
والذي يهمّنا هنا هو التعرّف على طبيعة الخدمة التي أداها الإمام الحسين (صلوات الله عليه) للدين الحنيف، وتشخيص الخطر الذي دفعه (عليه السّلام) عنه بنهضته المباركة وتضحياته الجسيمة.
فإنّ من الظاهر أنّ النهضة المباركة لم تمنع من استمرار العمل على نظام ولاية العهد في الخلافة من دون مراعاة أهلية المعهود له، واستمر ما سنّه معاوية في دول الإسلام المتعاقبة حتى تمّ إلغاء الخلافة في العصور القريبة.
وإذا كان كثير من المسلمين قد استنكروا على معاوية - في وقته - فتح هذا الباب، فإنّهم قد سكتوا عمّن بعده، وتأقلموا مع النظام المذكور كأمر واقع، بل أقرّ فقهاء الجمهور الخلافة المبتنية عليه، كما أقرّوا خلافة الأوّلين.
كما إنّ النهضة الشريفة قد جرّأت الأمويين على الدماء، كما توقّع الإمام الحسين (عليه السّلام) نفسه وبعض مَنْ نصحه بعدم الخروج على ما تقدّم(١) ، وجرى على ذلك من بعدهم من الحكّام في الدول المتعاقبة.
ومن الظاهر أيضاً أنّ النهضة الشريفة لم تخفّف من غلواء السلطات المتعاقبة باسم الإسلام في الظلم والطغيان، والأثرة والتعدّي، وانتهاك الحرمات العظام، والخروج عن أحكام الله (عزّ وجلّ) في مختلف المجالات.
وكذلك لم تمنع هذه النهضة من اختلاف المسلمين وتفرّقهم وتناحرهم، وانتهاكهم للحرمات، وتدهور أوضاعهم وتسافلها حتى انتهى بهم الأمر على ما هم عليه اليوم من الوهن والهوان.
كما إنّ من القريب جدّاً أنّه لو ابتُلي المسلمون بعد ذلك بمثل واقعة الطفّ في الظروف والمقارنات وانتهاك الحرمات لم يخرجوا منها بأحسن ممّا خرجوا في الواقعة المذكورة، بل قد يزيدون عليها إجراماً وبشاعة.
بل تسببت فاجعة الطفّ التي خُتمت بها هذه النهضة عن ردود فعل ومضاعفات زادت في عمق الخلاف بين شيعة أهل البيت والجمهور، وأُريقت بسببها أنهار من الدماء، وانتُهكت كثير من الحرمات.
وإلى ذلك يشير زهير بن القين (رضي الله عنه) في خطبته قُبيل المعركة حيث قال: يا أهل الكوفة، نذارِ لكم من عذاب الله نذارِ. إنّ حقّاً على المسلم نصيحة أخيه
____________________
١ - تقدّمت مصادره في/٦٤.
المسلم. ونحن حتى الآن أخوة، وعلى دين واحد وملّة واحدة ما لم يقع بيننا وبينكم السيف، وأنتم للنصيحة منّا أهل. فإذا وقع السيف انقطعت العصمة، وكنّا أُمّة وأنتم أُمّة...(١) .
كما إنّ هذه النهضة لم تقف حاجزاً دون تدهور المجتمع الإسلامي دينياً وخلقياً، بشرب الخمور، وظهور الفجور، واستعمال الملاهي، وأكل الحرام، والجرأة على الدماء... إلى غير ذلك.
وعلى ذلك لا بدّ من كون المكاسب الشريفة التي حصل عليها الدين الحنيف بسبب هذه النهضة العظيمة أموراً لا تتنافى مع كلّ ذلك، بل هي من الأهمية بحيث تناسب حجم التضحية، وتهون معها هذه الأمور. وتأتي محاولتنا هذه للتعرّف على تلك المكاسب وتقييمها.
والناظر في تراث أهل البيت (صلوات الله عليهم) يجد منهم التركيز على رفعة مقام الإمام الحسين (صلوات الله عليه)، وعلى شدّة ظلامته، وفداحة المصاب به، وإبراز الجوانب العاطفية في الواقعة، وعلى عظم الجريمة في نفسها، وشدّة النكير على القائمين بها، وكلّ مَنْ له دخل فيها من قريب أو بعيد، وخبثهم وسوء منقلبهم ونحو ذلك، ممّا يرجع إلى الإنكار عليهم ومحاولة التنفير منهم.
كلّ ذلك مع التأكيد المكثّف على أهمية إحياء الفاجعة، وتحرّي المناسبات للتذكير بها بمختلف الأساليب، من دون تركيز على الجهة التي نحن بصددها.
غاية الأمر أنّه تقدّم عن الإمام الحسين (صلوات الله عليه) ما يدلّ على
____________________
١ - تاريخ الطبري ٤/٣٢٣ - ٣٢٤ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/٦٣ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، البداية والنهاية ٨/١٩٤ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، صفة مقتله مأخوذة من كلام أئمّة الشأن، وغيرها من المصادر.
أنّ نتيجة نهضته وشهادته هي الفتح(١) ، كما تقدّم عن الإمام زين العابدين (صلوات الله عليه) ما يدلّ على أنّ بقاء الصلاة شاهد على انتصار الإمام الحسين (عليه الصلاة والسّلام)(٢) من دون أن يوضحا (عليهما السّلام) منشأ الفتح والشهادة المذكورين.
الزيارات المتضمّنة أنّ الهدف إيضاح معالم الدين
نعم، ورد في إحدى زيارات الإمام الحسين (صلوات الله عليه) المروية عن الإمام الصادق (صلوات الله عليه) قوله عنه (عليه السّلام): «فأعذر في الدعاء، وبذل مهجته فيك؛ ليستنقذ عبادك من الضلالة والجهالة، والعمى والشك والارتياب إلى باب الهدى من الردى»(٣) .
وفي زيارته (عليه السّلام) في يوم الأربعين عن الإمام الصادق (عليه السّلام) أيضاً قال: «فأعذر في الدعاء، ومنح النصح، وبذل مهجته فيك؛ ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة...»(٤) .
وقريب منه ما ورد في زيارته (عليه السّلام) ليلة عيد الفطر، وفي عيد الأضحى(٥) .
وذلك صريح في أنّ الهدف من النهضة الشريفة هو التعريف بالدين على حقيقته، وإيضاح معالمه، ووضوح الحجّة عليه، ورفع الارتياب والحيرة فيه،
____________________
١ - تقدّمت مصادره في/٤٥ - ٤٦.
٢ - تقدّمت مصادره في/٤٦.
٣ - كامل الزيارات/٤٠١، واللفظ له، تهذيب الأحكام ٦/٥٩، المزار للمفيد/١٠٨، وغيرها من المصادر.
٤ - مصباح المتهجد/٧٨٨، واللفظ له، تهذيب الأحكام ٦/١١٣، إقبال الأعمال ٣/١٠٢، وغيرها من المصادر.
٥ - مصباح الزائر/٣٣٢، المزار - لمحمد بن المشهدي/١٦٠، بحار الأنوار ٩٨/٣٥٤.
بغض النظر عن تطبيقه عملياً في الواقع الإسلامي أو عدمه.
وقد يناسب ذلك ما ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله) في حديث له مع أُبيّ بن كعب، وأنّه قال له: «إنّ الحسين بن علي في السماء أكبر منه في الأرض؛ فإنّه لمكتوب عن يمين عرش الله: مصباح الهدى، وسفينة النجاة...»(١) .
فإنّ الأئمّة (صلوات الله عليهم) وإن كانوا كلّهم هداة لدين الله تعالى وسفن نجاة الأُمّة، إلّا إنّ تخصيص الإمام الحسين (عليه السّلام) بذلك يناسب تميّزه في هداية الناس، ونجاتهم من هلكة التيه والحيرة والضلال.
كما ورد عن الإمام الحسين نفسه (صلوات الله عليه) أنّه ذكر في كلام له طويل دواعي خروجه وتعرّضه للقتل، وقال في آخره: «...( لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ ) »(٢) .
وربما تشير إلى ذلك العقيلة زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين (عليهما السّلام) فيما تقدّم من قولها في أواخر خطبتها - في التعقيب على الأبيات التي أنشدها يزيد متشفياً، وهو ينكت ثنايا الإمام الحسين (عليه السّلام) بمخصرته: فكد كيدك، واسعَ سعيك، وناصب جهدك؛ فوالله لا تمحو ذكرنا، ولا تُميت وحينا، ولا تُدرك أمدنا...(٣) .
وذلك يكشف عن أنّ دين الإسلام الخاتم للأديان قد تعرّض بسبب انحراف السلطة لخطر التحريف والتشويه، بحيث تضيع معالمه، ولا يتيسّر الوصول والتعرّف عليه لمَنْ يريد ذلك، كما حصل في الأديان السابقة، وأنّ
____________________
١ - بحار الأنوار ٣٦/٢٠٥، واللفظ له، عيون أخبار الرضا ٢/٦٢، كمال الدين وتمام النعمة/٢٦٥، وغيرها من المصادر.
٢ - اللهوف في قتلى الطفوف/٤٢.
٣ - راجع ملحق رقم ٤.
الإمام الحسين (عليه أفضل الصلاة والسّلام) قد واجه ذلك الخطر، ودفعه بنهضته المقدّسة، وما استتبعها من تضحيات جسام.
أهمية بقاء معالم الدين ووضوح حجّته
ومن الظاهر أنّ ذلك من أهمّ المقاصد الإلهية؛ فإنّ الله (عزّ وجلّ) لا بدّ أن يوضح الدين الحق، ويتم الحجّة عليه؛ ليتيسّر لطالب الحق الوصول إليه، والتمسّك به، و( لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ ) (١) .
وقد قال الله (عزّ وجلّ):( وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ) (٢) ، وقال تعالى:( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُول ) (٣) ، وقال سبحانه:( لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ) (٤) ... إلى غير ذلك.
تميّز الإسلام بما أوجب إيضاح معالمه وبقاء حجّته
وحقيقة الأمر: إنّ ذلك لم يستند لنهضة الإمام الحسين (صلوات الله عليه) وحدها، بل هو نتيجة أمرين امتاز بهما دين الإسلام العظيم:
الأوّل: بقاء القرآن المجيد في متناول المسلمين جميعاً، واتّفاقهم عليه، وحفظ الله (عزّ وجلّ) له من الضياع على عامّة الناس، ومن التحريف كما حصل في الكتب السماوية الأخرى.
الثاني: جهود جميع الأئمّة من أهل البيت (صلوات الله عليهم)، فإنّهم لما أُقصوا عن مراتبهم التي رتّبهم الله تعالى فيها، نتيجة انحراف مسار السلطة في
____________________
١ - سورة الأنفال/٤٢.
٢ - سورة التوبة/١١٥.
٣ - سورة الإسراء/١٥.
٤ - سورة النساء/١٦٥.
الإسلام، تعرّض دين الإسلام القويم لخطر التحريف والتشويه والضياع، كما تعرّضت لذلك جميع الأديان؛ فكان مقتضى ائتمان الله تعالى لهم (عليهم السّلام) على الدين، وجعلهم رعاة له أن يتحمّلوا مسؤوليتهم في درء الخطر المذكور.
فجدّوا وجهدوا في إيضاح الدين الحق، وإقامة الحجّة عليه بحيث لا يضيع على طالبه، رغم المعوّقات الكثيرة، والجهود المضادّة من قبل السلطات المتعاقبة وأتباعها.
وقد تظافرت جهودهم (عليهم السّلام) في خطوات متناسقة حقّقت هذا الهدف العظيم على النحو الأكمل، على ما سوف يظهر في محاولتنا هذه إن شاء الله تعالى.
غاية الأمر أنّ لنهضة الإمام الحسين (صلوات الله عليه) التي انتهت بفاجعة الطفّ - بأبعادها المتقدّمة - أعظم الأثر في ذلك، على ما سيتضح بعون الله (عزّ وجلّ).
ما يتوقّف عليه بقاء معالم الدين الحق ووضوح حجّته
هذا وقيام الحجّة على الدين الحق ووضوح معالمه مع ما مُني به الإسلام - كسائر الأديان - من الخلاف بين الأُمّة وتفرّقها، وشدّة الخصومة والصراع بينها يتوقف:
أوّلاً: على وجود مرجعية في الدين سليمة في نفسها متّفق عليها بين جميع الأطراف تنهض بإثبات الحق، والاستدلال عليه.
وثانياً: على وجود فرقة ظاهرة تدعو إلى الحق، وتنبّه الغافل؛ لوضوح أنّه مع الغفلة المطلقة لا يكفي وجود الدليل في قيام الحجّة ورفع العذر في حق الجاهل والمخطئ.
والظاهر إنّ لنهضة الإمام الحسين (صلوات الله عليه) أعظم الأثر في
كلا هذين الأمرين الدخيلين في قيام الحجّة على الحق ووضوحه، كما يتّضح ممّا يأتي من الحديث عمّا جناه دين الإسلام العظيم من ثمرات هذه النهضة المباركة والملحمة الإلهية المقدّسة.
إذا عرفت هذا فالكلام:
تارة: فيما كسبه الإسلام بكيانه العام.
وأُخرى: فيما كسبه الإسلام الحق المتمثّل بخط أهل البيت (صلوات الله عليهم) الذين جعلهم الله تعالى ورسوله مع الكتاب المجيد مرجعاً للأُمّة يعصمها من الضلال، وهو مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية (رفع الله تعالى شأنهم)، فهنا مطلبان:
المطلب الأوّل
فيما كسبه الإسلام بكيانه العام
تمهيد:
شرع الله (عزّ وجلّ) الأديان جميعاً؛ لتؤدّي دورها في إصلاح البشرية، وتقويم مسيرتها في الفترة الزمنية التي يشرع فيها الدين.
يجب بقاء الدين الحق واضح المعالم ظاهر الحجّة
وحيث كان المشرع للدين هو الله (عزّ وجلّ) الحكيم الأكمل، ذو العلم المطلق، المحيط بكلّ شيء، ولا يعزب عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء، فمن الطبيعي أن يكون الدين الذي يشرعه في فترة زمنية معينة، ويفرض على عباده الالتزام به في تلك الفترة، واجداً تشريعياً لمقوّمات بقائه، واضح المعالم، مسموع الدعوة، ظاهر الحجّة( لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ ) (١) ، بحيث يكون الخروج عنه خروجاً بعد البيان والحجّة، كما قال (عزّ من قائل):( وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ) (٢) ؛ لئلاّ يقولوا:( رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى ) (٣) .
____________________
١ - سورة الأنفال/٤٢.
٢ - سورة التوبة/١١٥.
٣ - سورة طه/١٣٤.
لا بدّ من رعاية المعصوم للدين
وذلك لا يكون إلّا بأن يكون الأمين على الدين، والمرجع للأُمّة فيه في فترة تشريعه معصوماً لا يزيغ عن الدين، ولا يخطأ فيه، نبيّاً كان أو وصيّاً لنبي.
وعلى ذلك جرت الأديان السماوية فيما روي عن النبي والأئمّة من آله (صلوات الله عليهم أجمعين) مستفيضاً، بل متواتراً.
وروى الجمهور كثيراً من مفردات ذلك في الأديان السابقة(١) ، بل ورد في بعض روايات الجمهور أنّ الله سبحانه وتعالى أوحى إلى آدم (عليه السّلام): «إنّي قد استكملت نبوّتك وأيّامك، فانظر الاسم الأكبر، وميزان علم النبوّة فادفعه إلى ابنك شيث؛ فإنّي لم أكن لأترك الأرض إلّا وفيها عالم يدلّ على طاعتي، وينهى عن معصيتي»(٢) .
وهو عين ما يبتني عليه مذهب الإمامية الاثني عشرية - رفع الله تعالى
____________________
١ - مجمع الزوائد ٩/١١٣ كتاب المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، باب فيما أوصى به (رضي الله عنه)، فضائل الصحابة - لابن حنبل ٢/٦١٥ ومن فضائل علي (رضي الله عنه) من حديث أبي بكر بن مالك عن شيوخه غير عبد الله، تاريخ دمشق ٢٣/٢٧١ في ترجمة شيث، ويُقال شيث بن آدم واسمه هبة الله، و٥٠/٩ في ترجمة كالب بن يوقنا بن بارص، و٦١/١٧٥ في ترجمة موسى بن عمران بن يصهر، و٦٢/٢٤١ في ترجمة نوح بن لمك بن متوشلخ، تهذيب الأسماء ١/٢٣٦، مسائل الإمام أحمد ١/١٢ ذكر ترتيب كبار الأنبياء، العظمة ٥/١٦٠٢، ١٦٠٤، المعجم الكبير ٦/٢٢١ في ما رواه أبو سعيد عن سلمان (رضي الله عنه)، تفسير القرطبي ٦/١٤٠، و١٥/١١٥، تفسير البغوي ٢/٣٠ - ٣١، تفسير الطبري ٢/٨٠٨، الدرّ المنثور ١/٣١٤، الطبقات الكبرى ١/٣٧ - ٣٨، ٤٠ ذكر من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأنبياء، تاريخ الطبري ١/١٠٢ - ١٠٣ ذكر ولادة حواء شيث، وص ١٠٧، ١١٠ - ١١١ ذكر وفاة آدم (عليه السّلام)، وص ٣٢٢، ٣٢٤ ذكر أمر بني إسرائيل والقوم الذين كانوا بأمرهم، و٢/٣١ - ٣٢ ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر بعض أخبار آبائه وأجداده، الكامل في التاريخ ١/٤٧ ذكر الأحداث التي كانت في عهد آدم (عليه السّلام) في الدنيا، ذكر ولادة شيث، وغيرها من المصادر.
٢ - العظمة ٥/١٦٠٢.
شأنهم - من أنّ الأرض لا تخلو من إمام وحجّة، تبعاً لما استفاض - بل تواتر - عن النبي والأئمّة من آله (صلوات الله عليهم أجمعين)(١) : «ما اختلفت أُمّة بعد نبيّها إلّا غلب أهل باطلها أهل حقّها».
إلاّ إنّ الأديان جميعاً قد ابتُليت بالاختلاف بعد أنبيائها. ومن الطبيعي - إذا لم تتدخّل العناية الإلهية بوجه خاص - أن يكون الظاهر في آخر الأمر هو الباطل، وتكون الغلبة والسلطة له:
أوّلاً: لأنّ مبدئية صاحب الحقّ المعصوم تجعله يحمل الناس على مرّ الحقّ، ولا يُهادن فيه، وذلك يصعب على أكثر الناس، كما قال الإمام الحسين (صلوات الله عليه): «الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درّت معايشهم، فإذا محّصوا بالبلاء قلّ الديانون»(٢) . وحينئذٍ يخذلونه ويتفرّقون عنه، بل كثيراً ما يتحزّبون ضدّه.
وثانياً: لأنّ مبدئية المعصوم تمنعه من سلوك الطرق الملتوية وغير المشروعة، والمنافية للمبادئ الإنسانية السامية في صراعه مع الباطل. وهي
____________________
١ - تذكرة الحفاظ ١/١٢ في ترجمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، حلية الأولياء ١/٨٠ في ترجمة علي بن أبي طالب، تذكرة الحفّاظ ٢٤/٢٢١ في ترجمة كميل بن زياد بن نهيك، كنز العمّال ١٠/٢٦٣ - ٢٦٤ ح ٢٩٣٩١، تاريخ دمشق ١٤/١٨ في ترجمة الحسين بن أحمد بن سلمة، و٥٠/٢٥٤ في ترجمة كميل بن زياد بن نهيك، المناقب للخوارزمي/٣٦٦ الفصل الرابع والعشرون في بيان شيء من جوامع كلمه وبوالغ حكمه، ينابيع المودّة ١/٨٩، جواهر المطالب ١/٣٠٣، وغيرها من المصادر.
وأمّا المصادر الشيعية: فقد رويت في نهج البلاغة ٤/٣٧ - ٣٨، والمحاسن ١/٣٨، وبصائر الدرجات/٥٧، والإمامة والتبصرة/٢٦، والكافي ١/١٧٨ - ١٧٩، والخصال - للصدوق/٤٧٩، وكمال الدين وتمام النعمة/٢٢٢، ٣١٩، ٤٠٩، ٤٤٥، ٥١١، وكفاية الأثر/١٦٤، ٢٩٦، وبحار الأنوار ٢٣/١ - ٦٥، وغيرها من المصادر.
٢ - تقدّمت مصادره في/٣٦.
نقطة ضعف مادية فيه، كثيراً ما يستغلّها الطرف المبطل في الصراع، ويقوى بسببها، فيغلب المحق ويظهر عليه.
وإلى ذلك يشير أمير المؤمنين (عليه السّلام) في قوله: «قد يرى الحوّل القلّب وجه الحيلة، ودونه مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي العين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها مَنْ لا حريجة له في الدين»(١) .
ولعلّه لذا ورد أنّه ما اختلفت أُمّة بعد نبيّها إلّا غلب أهل باطلها أهل حقّها(٢) .
استغلال السلطة المنحرفة الدعوة ومبادئها لصالحها
ونتيجة لذلك يستولي أهل الباطل، ويتّخذون الدين ذريعة لخدمة مصالحهم وسلطانهم، ولتبرير نزواتهم، وإشباع شهواتهم، ولو بتحريفه عن حقيقته والخروج عن حدوده؛ لأنّ لهم القوّة والسطوة، وبيدهم التثقيف والدعاية والإعلام.
ومن ثمّ كان منشأ التحريف في الدين غالباً هو تحكّم غير المعصوم فيه من سلطان مبطل، أو مؤسسة منسّقة مع السلطان المذكور، بل ذلك هو منشأ التحريف في جميع الدعوات والأنظمة التي تتبنّاه
____________________
١ - نهج البلاغة ١/٩٢، واللفظ له، ربيع الأبرار ٤/٣٤٢ باب الوفاء وحسن العهد ورعاية الذمم، التذكرة الحمدونية ٣/١ الباب السابع في الوفاء والمحافظة والأمانة والغدر والملل والخيانة.
٢ - مجمع الزوائد ١/١٥٧ كتاب العلم، باب في الاختلاف، واللفظ له، المعجم الأوسط ٧/٣٧٠، فيض القدير ٥/٤١٥، حلية الأولياء ٤/٣١٣، تذكرة الحفاظ ١/٨٧ في ترجمة الشعبي، سير أعلام النبلاء ٤/٣١١ في ترجمة الشعبي، تاريخ الإسلام ٧/١٣١ في ترجمة عامر بن شرحبيل الشعبي، ذكر من اسمه شعبة/٦٨، كنز العمال ١/١٨٣ ح ٩٢٩، الجامع الصغير - للسيوطي ٢/٤٨١ ح ٧٧٩٩، وقعة صفين/٢٢٤، ينابيع المودّة ٢/٨٠، وغيرها من المصادر.
الجهات المتنفّذة والقوى الحاكمة؛ حيث تتّخذ منها أداة لتقوية نفوذها، وتركيز حكمها وسلطانها، ولو على حساب الأسس التي تقوم تلك الدعوات والأنظمة والتعاليم التي تتبناها.
كما يتضح ذلك بأدنى نظرة في واقع الأنظمة والدعوات التي تبنّتها الدول والحكومات عبر التاريخ الطويل وحتى عصرنا الحاضر؛ حيث لا نجد دعوة حقّ أو باطل قامت على أساسها دولة في ظلّ غير المعصوم بقيت محافظة على أصالتها ونقائها، وعلى تعاليمها ومفاهيمها التي أُسست عليها.
لكنّ الله (عزّ وجلّ) قد أخذ على نفسه أن يتمّ الحجّة على الحقّ كما سبق، بل هو اللازم عليه بمقتضى عدله وحكمته؛ أوّلاً: لقبح العقاب بلا بيان، وثانياً: لعدم تحقّق حكمة جعل الدين وإلزام الناس به إلّا بوصوله وقيام الحجّة عليه.
غلبة الباطل لا توجب ضياع الدين الحقّ وخفاء حجّته
وحينئذ لا بدّ من كون غلبة الباطل وتسلّطه بنحو لا يمنع من قيام الحجّة على بطلان دعوته، وصحّة دعوة الحقّ؛ بحيث تنبّه الغافل لذلك، وتقطع عذر الجاهل.
كما لا بدّ أن تبقى الدعوة المحقّة التي يرعاها المرجع المعصوم شاخصة ناطقة؛ بحيث لو طلبها مَنْ شاء من أهل ذلك الدين وغيرهم، ونظر في حجّتها بموضوعية تامّة، بعيداً عن التعصّب والعناد، لوصل إليها.
ونتيجة لذلك لا بدّ من كون الخلاف للحقّ، والخروج عنه ليس لقصور في بيانه وخفاء فيه، بل عن تقصير من الخارج بعد البيّنة، وقيام الحجّة الكافية على الحقّ.
كما قال الله تعالى:( كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ
وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاس فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ ) (١) .
وقال سبحانه:( إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ ) (٢) .
وقال (عزّ وجلّ):( وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) (٣) .
وقال تعالى:( وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى ) (٤) .
وفي حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «قد تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلّا هالك»(٥) ... إلى غير ذلك.
____________________
١ - سورة البقرة/٢١٣.
٢ - سورة آل عمران/١٩.
٣ - سورة آل عمران/١٠٥.
٤ - سورة طه/١٣٤.
٥ - مسند أحمد ٤/١٢٦ حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واللفظ له، تفسير القرطبي ٧/١٣٨ - ١٣٩. سنن ابن ماجة ١/١٦ باب اتّباع الخلفاء الراشدين المهديين، المستدرك على الصحيحين ١/٩٦ كتاب العلم، السنة - لابن أبي عاصم ١/١٩، ٢٦ - ٢٧، المعجم الكبير ١٨/٢٤٧ في ما رواه عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية، وص ٢٥٧ في ما رواه حبير بن نفير عن العرباض، مسند الشاميين ٣/١٧٣، الترغيب والترهيب - للمنذري ١/٤٧، مصباح الزجاجة ١/٥ كتاب اتّباع السُنّة، وغيرها من المصادر الكثيرة.
هكذا روي الحديث في هذه المصادر. لكن رواه الشيخ الجليل الحسن بن أبي الحسن الديلمي كما بلي: «قال العرباض بن ساربة: وعظنا رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) موعظة ذرفت العيون، ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: لقد تركتكم على الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدها إلا هالك. ومن يعش منكم يرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بما عرفتم من سنتي بعدي، وسنة الخلفاء الراشدين =
لا ملزم بوضوح معالم الدين بعد نسخه
نعم، إنّما يلزم على الله (عزّ وجلّ) إبقاء الحجّة ووضوح معالم الحقّ في الدين الذي يقع الاختلاف فيه مادام ذلك الدين مشروعاً نافذاً على الناس، بحيث يجب عليهم التديّن به، والعمل بأحكامه.
أمّا إذا انتهى أمده، ونُسخ بدين جديد - يجب على الناس التدين به، والعمل بأحكامه - فلا ملزم ببقاء الحجّة الواضحة على دعوة الحقّ في الدين المنسوخ، ولا محذور في ضياع معالمه.
بل لا أثر عملي لظهور دعوة الحقّ في الدين المنسوخ ووضوح حجّته بعد عدم وجوب اعتناقه، والتدين به، ولا محذور في انفراد دعوة الباطل من ذلك الدين في الساحة؛ إذ يكفي في تحقّق حكمة جعل الدين، ودفع محذور العقاب بلا بيان، سماع دعوة الدين الجديد الناسخ - الذي يجب التديّن به واتّباعه - ووضوح معالمه، وقيام الحجّة عليه، كما هو ظاهر.
كون الإسلام خاتم الأديان يستلزم بقاء معالمه ووضوح حجّته
وبذلك يظهر اختلاف دين الإسلام العظيم عن بقيّة الأديان؛ إذ حيث كان هو الدين الخاتم الذي ليس بعده دين، والذي يجب على الناس اعتناقه والتديّن به مادام الإنسان يعمر الأرض، فلا بدّ من بقاء دعوة الحقّ فيه مسموعة الصوت، ظاهرة الحجّة ما بقيت الدنيا.
وهو ما حصل بتسديد الله (عزّ وجلّ) ورعايته، وبجهود وتضحيات أهل
____________________
= من أهل بيتي، فعضوا عليهم بالنواجذ، وأطيعوا الحق ولو كان صاحبه عبداً حبشياً، فإن المؤمن كالجمل الآلوف حيثما قيد استقاد». إرشاد القلوب ج: ١ ص: ٣٧ الباب الخامس: في التخويف والترهيب.
البيت (صلوات الله عليهم) الذين ائتمنهم تعالى على دينه، وجعلهم - مع كتابه المجيد - مرجعاً للأُمّة فيه، وما استتبع ذلك من جهود وتضحيات شيعتهم ومواليهم الذين آمنوا بقيادتهم، وتفاعلوا معهم دينياً وعاطفياً.
وكان لنهضة الإمام الحسين (صلوات الله عليه)، وتضحياته الجسيمة أعظم الأثر في ذلك، كما نرجو إيضاحه في حديثنا هذا بعون من الله تعالى وتوفيقه وتسديده.
هذا وسوف يتّضح إن شاء الله تعالى أنّ الخطر الذي تصدى الإمام الحسين (عليه السّلام) لدفعه لم ينشأ من استيلاء الأمويين على الحكم، أو استيلاء يزيد عليه خاصة، غاية الأمر أن يكون الخطر قد تفاقم بذلك، أو أنّ الفرصة قد سنحت للتصدّي لذلك الخطر، ولم تسنح قبل ذلك.
وكيف كان فالحديث:
أوّلاً: في اتّجاه مسيرة الإسلام بعد الانحراف عن خطّ أهل البيت (صلوات الله عليهم)، واستيلاء غيرهم على السلطة، وما من شأنه أن يترتّب على الانحراف المذكور لو لم يكبح جماحه.
وثانياً: في جهود أهل البيت (صلوات الله عليهم) في كبح جماح الانحراف من أجل خدمة دعوة الإسلام بكيانه العام. فالكلام في مبحثين:
المبحث الأوّل
فيما من شأنه أن يترتّب على انحراف مسار
السلطة في الإسلام لو لم يكبح جماحها
من الطبيعي أن يجري الله (عزّ وجلّ) في دين الإسلام القويم تشريعاً على سنن الأديان السابقة، فلا يتركه بعد ارتحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرفيق الأعلى عرضة للاختلاف والاجتهادات المتضاربة، بل يوكله للمعصومين الذين يؤمن عليهم الخطأ والاختلاف.
بل هو أولى من الأديان السابقة بذلك بعد أن كان هو الدين الخاتم الذي لا ينتظر أن يشرّع بعده دين ونبوّة تصحّح الأخطاء والخلافات التي تحصل بين معتنقيه، كما تصدّى هو لتصحيح الأخطاء والخلافات التي حصلت بين معتنقي الأديان السابقة عليه.
قال الله (عزّ وجلّ):( تَاللهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ) (١) .
وقال تعالى:( إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ * وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ) (٢) .
____________________
١ - سورة النحل/٦٣ - ٦٤.
٢ - سورة النمل/٧٦ - ٧٧.
وقال سبحانه:( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ) (١) ... إلى غير ذلك.
وقد كان المعصومون الذين أوكل الله تعالى دينه العظيم إليهم، وجعلهم مرجعاً للأُمّة فيه، هم الأئمّة الاثني عشر من أهل البيت (عليهم السّلام)، أوّلهم الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وآخرهم إمام العصر والزمان الحجّة بن الحسن المهدي المنتظر (صلوات الله عليهم أجمعين).
ولسنا الآن بصدد إثبات ذلك، بل هو موكول لعلم الكلام، وكتب العقائد الكثيرة، ومنها كتابنا (أصول العقيدة).
ولأهمية أمر الإمامة في الدين فقد أكّد الكتاب المجيد والسُنّة النبويّة الشريفة على أمور:
وجوب معرفة الإمام والإذعان بإمامته
الأوّل: وجوب معرفة الإمام والبيعة له؛ فقد استفاض عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «مَنْ مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية»(٢) ، أو: «مَنْ مات بغير إمام مات ميتة جاهلية»(٣) ، أو: «مَنْ مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة
____________________
١ - سورة المائدة/١٥.
٢ - كمال الدين وتمام النعمة/٤٠٩، كفاية الأثر/٢٩٦، إعلام الورى بأعلام الهدى ٢/٢٥٣، ينابيع المودّة ٣/٣٧٢، الجواهر المضية في طبقات الحنفية ٢/٤٥٧، وغيرها من المصادر.
٣ - مسند أحمد ٤/٩٦ حديث معاوية بن أبي سفيان، حلية الأولياء ٣/٢٢٤ في ترجمة زيد بن أسلم، المعجم الكبير ١٩/٣٨٨ في ما رواه شريح بن عبيد عن معاوية، مسند الشاميين ٢/٤٣٧ ما انتهى إلينا من مسند ضمضم بن زرعة، ما رواه ضمضم عن شريح بن عبيد، مجمع الزوائد ٥/٢١٨ كتاب الخلافة، باب لزوم الجماعة وطاعة الأئمّة والنهي عن قتالهم، مسند أبي داود الطيالسي/٢٥٩ ما رواه أبو سلمة عن ابن عمر، كنز العمّال ١/١٠٣ ح ٤٦٤، و٦/٦٥ ح ١٤٨٦٣، علل الدارقطني ٧/٦٣ من حديث الصحابة عن معاوية (رضي الله عنه)، وغيرها من المصادر.
جاهلية»(١) ، أو نحو ذلك.
وجوب طاعة الإمام وموالاته والنصيحة له
الثاني: وجوب الطاعة لأولياء أمور المسلمين وأئمّتهم، وموالاتهم والنصيحة لهم. قال الله (عزّ وجلّ):( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ) (٢) .
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته في مسجد الخيف: «ثلاث لا يغلّ عليهنّ قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمّة المسلمين، واللزوم لجماعتهم؛ فإنّ دعوتهم محيطة من ورائهم...»(٣) ... إلى غير ذلك ممّا يفوق حدّ الإحصاء.
____________________
١ - صحيح مسلم ٦/٢٢ كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن، السنن الكبرى ٨/١٥٦ كتاب قتال أهل البغي، جماع أبواب الرعاة، باب الترغيب في لزوم الجماعة والتشديد على من نزع يده من الطاعة، مجمع الزوائد ٥/٢١٨ كتاب الخلافة، باب لزوم الجماعة وطاعة الأئمّة والنهي عن قتالهم، السُنّة - لابن أبي عاصم/٤٨٩ ح ١٠٥٧، وص ٥٠٠ ح ١٠٨١، المعجم الكبير ١٩/٣٣٤ في ما رواه ذكوان أبو صالح السمان عن معاوية، فتح الباري ١٣/٥، كنز العمّال ٦/٥٢ ح ١٤٨١٠، وغيرها من المصادر الكثيرة.
٢ - سورة النساء/٥٩.
٣ - الكافي ١/٤٠٣، واللفظ له، سنن الترمذي ٥/٣٤ كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، باب ما جاء في الحثّ على تبليغ السماع، سنن ابن ماجة ١/٨٤ باب من بلغ علم، المستدرك على الصحيحين ١/٨٧ كتاب العلم، مسند أحمد ٤/٨٢ في حديث جبير بن مطعم، صحيح ابن حبان ١/٢٧٠ كتاب العلم، باب الزجر عن كتبة المرء السنن مخافة أن يتكل عليها دون الحفظ لها، ذكر رحمة الله (جلّ وعلا) من بلغ الأُمّة حديثاً صحيحاً عنه، مجمع الزوائد ١/١٣٧ - ١٣٩ كتاب العلم، باب في سماع الحديث وتبليغه، الأحاديث المختارة ٦/٣٠٨ في ما رواه عقبة بن وساج عن أنس، سنن الدارمي ١/٧٥ باب الاقتداء بالعلماء، وغيرها من المصادر الكثيرة جدّاً.
لزوم جماعة المسلمين والمؤمنين وحرمة التفرّق
الثالث: لزوم جماعة الأئمّة التي هي جماعة المؤمنين، واتّباع سبيلهم، والنهي عن الاختلاف والتفرّق، قال الله تعالى:( وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا ) (١) .
وقال (عزّ وجلّ):( وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) (٢) .
وقال سبحانه:( إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ) (٣) .
وكذا ما سبق من خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد الخيف، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ترجعوا بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»(٤) .
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «أنا آمركم بخمس، الله أمرني بهنّ: بالجماعة، والسمع، والطاعة، والهجرة، والجهاد في سبيل الله؛ فإنّه مَنْ خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، إلى أن يرجع...»(٥) ... إلى غير ذلك.
____________________
١ - سورة آل عمران/١٠٣.
٢ - سورة آل عمران/١٠٥.
٣ - سورة الأنعام/١٥٩.
٤ - صحيح البخاري ١/٣٨ كتاب العلم، باب الإنصات للعلماء، و٢/١٩١ - ١٩٢ كتاب الحجّ، باب الخطبة أيام منى، و٥/١٢٦ كتاب المغازي، باب حجّة الوداع، و٧/١١٢ كتاب الأدب، باب ما جاء في قول الرجل ويلك، و٨/١٦ كتاب الحدود، باب الحدود كفّارة، وص ٣٦ كتاب الديات، وص ٩١ كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ترجعوا بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض، صحيح مسلم ١/٥٨ كتاب الإيمان، باب لا ترجعوا بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض، و٥/١٠٨ كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، وغيرهما من المصادر الكثيرة جدّاً.
٥ - مسند أحمد ٤/٢٠٢ حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واللفظ له، و٥/٣٤٤ حديث أبي مالك الأشعري، سنن الترمذي ٤/٢٢٦ أبواب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، باب ما جاء مثل الصلاة والصيام والصدقة، المستدرك على الصحيحين ١/١١٧ كتاب العلم، الحديث الرابع فيما =
وقد أجمع الجمهور على حرمة الخروج على الإمام العادل - فضلاً عن المعصوم - وأنّ الخارج عليه باغٍ يجب على المسلمين قتاله حتى يفيء للطاعة.
قال الله (عزّ وجلّ):( وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ ) (١) .
أهمية هذه الأمور في نظم أمر الدين والمسلمين
وبالتأكيد على هذه الأمور يُقطع الطريق تشريعياً على مَنْ يحاول زرع الأشواك في طريق الإمام المعصوم وإتعابه، وعلى مَنْ يتوهّم أو يختلق المبرّرات لمخالفة أمره، فضلاً عن الخروج عليه والانحياز عن جماعته.
وهو أمر ضروري في مسيرة دولة الحقّ؛ لأنّ الدولة لا تقوم إلّا بالطاعة المطلقة، إذ كثيراً ما يخفى على الرعية وجه الحكمة في موقف الإمام المعصوم من الأحداث. نظير ما حدث للمسلمين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية وغيره.
فإذا فتح باب الاجتهاد والخلاف على الإمام عاقه ذلك عن أداء وظيفته، وتيسّر للمنحرفين والنفعيين اختلاق المبرّرات لمخالفته والخروج عليه، كما هو ظاهر، وقد حاولنا توضيح ذلك عند الاستدلال على وجوب عصمة الإمام من كتابنا (أصول العقيدة).
____________________
= يدلّ على أن إجماع العلماء حجّة، السنن الكبرى - للبيهقي ٨/١٥٧ كتاب قتال أهل البغي، باب الترغيب في لزوم الجماعة والتشديد على من نزع يده من الطاعة، صحيح ابن خزيمة ٣/١٩٦ كتاب الصيام، باب ذكر تمثيل الصائم في طيب ريحه بطيب ريح المسك إذ هو أطيب الطيب، مجمع الزوائد ٥/٢١٧ كتاب الخلافة، باب لزوم الجماعة وطاعة الأئمّة والنهي عن قتالهم، المصّنف - لعبد الرزاق ٣/١٥٧ كتاب الصلاة، باب تزيين المساجد والممر في المسجد، المصنّف - لابن أبي شيبة ٧/٢٢٧ كتاب الإيمان والرؤية، وغيرها من المصادر الكثيرة جدّاً.
١ - سورة الحجرات/٩.
طاعة الإمام المعصوم مأمونة العاقبة على الدين والمسلمين
كما إنّ الطاعة المذكورة مأمونة العاقبة على الدين والمسلمين بعد فرض عصمة الإمام، وكونه مسدّداً من قبل الله (عزّ وجلّ).
كما قالت الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (صلوات الله عليه) في بيان حال الأُمّة لو وليها أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسّلام): «وتالله، لو مالوا عن المحجّة اللائحة، وزالوا عن قبول الحجّة الواضحة، لردّهم إليها وحملهم عليها، ولسار بهم سيراً سجحاً لا يكلم حشاشه، ولا يكِلّ سائره، ولا يمُلّ راكبه، ولأوردهم منهلاً نميراً صافياً روياً تطفح ضفتاه، ولا يترنق جانباه، ولأصدرهم بطاناً، ونصح لهم سراً وإعلاناً»(١) .
طاعة الإمام ولزوم جماعته مدعاة للطفّ الإلهي
بل الطاعة المذكورة مدعاة للطفّ الإلهي والفيض الربّاني على الأُمّة بعد أن اجتمعت على طاعة الله (عزّ وجلّ)، وانضمّت تحت راية عدله التي رفعها له. كما قال الله (عزّ وجلّ):( وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ ) (٢) .
وقال سبحانه تعالى:( وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ * وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّن رَّبِّهِمْ لأكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ) (٣) .
وقال سلمان الفارسي: لو بايعوا علياً لأكلوا من فوقهم ومن تحت
____________________
١ - راجع ملحق رقم ٢.
٢ - سورة الأعراف/٩٦.
٣ - سورة المائدة/٦٥ - ٦٦.
أرجلهم(١) .
وقال أبو ذر ّ: أما لو قدّمتم مَنْ قدّم الله، وأخّرتم من أخّر الله، وأقررتم الولاية والوراثة في أهل بيت نبيّكم، لأكلتم من فوق رؤوسكم ومن تحت أقدامكم(٢) .
انحراف مسار السلطة في الإسلام
لكن أمر الإسلام عملياً بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجرِ على ما أراده الله (عزّ وجلّ) ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بل تعثّرت الأُمّة في طريقها، وانحرفت عن خطّ أهل البيت (صلوات الله عليهم)، وخرجت بالسلطة عنهم، وعن الالتزام بالنصّ على الإمام المعصوم، بل من دون نظام بديل حتى لو لم يكن إلهي.
وصار المعيار في الإمامة البيعة ولو بالقسر والقهر - مهما كانت منزلة المبايَع نسباً، وأثراً في الإسلام، وسلوكاً في نفسه ومع الناس - اعترافاً بالأمر الواقع ورضوخاً له.
إنكار أمير المؤمنين والزهراء (عليهما السّلام) لِما حصل
وقد وقف أمير المؤمنين الإمام علي (صلوات الله عليه) وخاصة أصحابه ممّن ثبت معه موقف المنكر لذلك؛ إقامة للحجّة.
كما استثمرت الصديقة سيّدة النساء فاطمة الزهراء (صلوات الله عليه) حصانتها نسبياً فدعمت موقفهم، وأصحرت بالشكوى والإنكار لِما حصل في خطبتيها الجليلتين(٣) ، وأحاديثها ومواقفها الصلبة في بقيّة عمرها القصير،
____________________
١ - أنساب الأشراف ٢/٢٧٤ أمر السقيفة.
٢ - تاريخ اليعقوبي ٢/١٧١ في أيام عثمان.
٣ - راجع ملحق رقم ١ و ٢.
وأيّامها القليلة، مؤكدة على أن الخلافة والإمامة حق لأهل البيت (صلوان الله عليهم) جعله الله تعالى كما جعل فرائض الإسلام، وأنه لا عذر لهم في الخروج عن ذلك، ولا مجال لتبريره، بل سوف يتحملون مسؤولية ما حصل في الدنيا والآخرة. وقد أصرّت على مواقفها السبيلة منهم حتى قضت نحبها، في تفاصيل كثيرة لا يسع المقام استقصاءها.
اضطرار أمير المؤمنين (عليه السّلام) للمسالمة
ثمّ اضطر أمير المؤمنين (عليه السّلام) وخاصة أصحابه للسكوت والمسالمة بعد أن ظهر إصرار المستولين على السلطة وعنفهم؛ حفاظاً منه (صلوات الله عليه) على كيان الإسلام العام من الانهيار، وإبقاءً منه (عليه السّلام) على حياته وحياة البقيّة الصالحة؛ لتؤدّي دورها في التعريف بالدين الصحيح، والدعوة له عندما يتيسّر لهم ذلك على ما ذكرناه في خاتمة كتابنا (أصول العقيدة).
أثر الفتوح في تركز الإسلام واحترام رموز السلطة
ولم تمضِ مدّة طويلة حتى توجّه المسلمون للحروب خارج الجزيرة العربية، وكانت نتيجتها الفتوح الكبرى، وما استتبعها من الغنائم العظيمة التي لم يكونوا يحلمون بها، ثمّ الشعور بالعزّة والرفعة؛ فتركز الإسلام وحسن في نفوسهم، وفرض احترامه على العالم، واتّسعت رقعته، وتوطّدت أركانه في الأرض، ودخلت فيه الشعوب المختلفة.
ومن الطبيعي - بعد ذلك - أن لا يُعرف من الإسلام ولا يُحترم إلّا الإسلام الذي تحقّق به الفتح الذي ابتنت الخلافة والحكم فيه على الخروج على النظام الإلهي، واعتماد القوّة؛ فصار له ولرموزه المكانة العُليا في النفوس، ومنها تؤخذ
أصوله وثوابته العقائدية، ويرجع إليها في فروعه وأحكامه وإرشاداته وآدابه وتاريخه وأمجاده وجميع شؤونه. فهي المرجع للإسلام والمسلمين في السياسة والإدارة والعلم والثقافة، كما يظهر بمراجعة التراث المتعلق بتلك الفترة. وربما يأتي بعض مفردات ذلك.
وأكّد ذلك الخطوات التي خطتها السلطة في سبيل فرض احترامه، وتثبيت شرعيته، بل تقديسه، ممّا يأتي التعرّض له إن شاء الله تعالى.
غياب الإسلام الحقّ ورموزه عن ذاكرة المسلمين
وصار الإسلام الحقّ غريباً على جمهور المسلمين، وجُهل مقام رموزه وحملته، بالرغم ممّا لهم من مقام ديني رفيع نوّه عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصورة مكثفة، وأنّ لهم أعظم الأثر في الإسلام.
وحتى في تلك الحروب - التي كانت نتيجتها الفتوح الكبرى - دعماً وتوجيهاً ومشاركة؛ اهتماماً منهم بكيان الإسلام العام من أجل أن تصل دعوته إلى العالم، وتتعرّف عليه الأُمم المختلفة، ويأخذ موقعه من نفوسها، وإن استغلّت السلطة الرسمية القائمة ذلك كلّه لصالحها، وتثبيت موقعها، وفرض احترامها.
دعم أمير المؤمنين (عليه السّلام) السلطة اهتماماً بكيان الإسلام
فمثلاً يظهر من بعض الروايات أنّ شعور جمهور الصحابة بعدم شرعية الانحراف الذي حصل جعلهم يتوقّفون عن الحرب في ظلّ السلطة الجديدة في حروب الردّة في الجزيرة العربية، فضلاً عن غزو الكفّار فيها وفي خارجها؛ وقد أوجب ذلك توقّف النشاط العسكري الإسلامي، وتعرّض الإسلام للخطر.
فاضطر أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسّلام) لدعم السلطة؛ من
أجل إضفاء الشرعية على القتال تحت ظلّها.
فقد روى المدائني عن عبد الله بن جعفر بن عون قال: لما ارتدّت العرب مشى عثمان إلى علي، فقال: يابن عم، إنّه لا يخرج أحد إليّ. فقال: [إلى قتال. صح] هذا العدو، وأنت لم تُبايع؟ فلم يزل به حتى مشى إلى أبي بكر، فقام أبو بكر إليه واعتنقه، وبكى كلّ واحد إلى صاحبه، فبايعه. فسرّ المسلمون، وجدّ الناس في القتال، وقطعت البعوث(١) .
وقال (صلوات الله عليه) في كتابه إلى أهل مصر: «فما راعني إلّا انثيال الناس على فلان يُبايعونه، فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلماً أو هدماً تكون المصيبة به عليّ أعظم من فوت ولايتكم...؛ فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهق، واطمأنّ الدين وتنهنه»(٢) .
وقال اليعقوبي: وأراد أبو بكر أن يغزو الروم، فشاور جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقدّموا وأخّروا. فاستشار علي بن أبي طالب فأشار أن يفعل، فقال: «إن فعلت ظفرت». فقال: بشرت بخير(٣) .
وكان (صلوات الله عليه) يسعفهم بتوجيهاته وصائب رأيه.
فمثلاً لما استشاره عمر في الخروج لحرب الروم أشار عليه بترك الخروج(٤) . وكذا لما استشاره في الخروج لحرب الفرس(٥) ، كما أوضح له آلية الحرب، وكيفية
____________________
١ - أنساب الأشراف ٢/٢٧٠ أمر السقيفة، الشافي في الإمامة ٣/٢٤١.
٢ - نهج البلاغة ٣/١١٩.
٣ - تاريخ اليعقوبي ٢/١٣٣ في أيام أبي بكر، وقريب منه في الفتوح - لابن أعثم ١/٨٢ ذكر كيفية الاستيلاء على بلاد الشام في خلافة الصديق (رضي الله عنه).
٤ - نهج البلاغة ٢/١٨.
٥ - نفس المصدر ٢/٢٩.
تجنيد المسلمين لها(١) .
وما أكثر ما جنّبهم المآزق حتى تكرّر عن عمر أنّه كان يتعوّذ من معضلة ليس لها أبو الحسن(٢) .
وقال: «لولا علي لهلك عمر»(٣) ... إلى غير ذلك ممّا هو كثير جدّاً، ويسهل على الباحث الاطّلاع عليه(٤) .
____________________
١ - نهج البلاغة ٢/٢٩، تاريخ الطبري ٣/٢١١ - ٢١٢ أحداث سنة إحدى وعشرين من الهجرة، ذكر الخبر عن وقعة المسلمين والفرس بنهاوند، الكامل في التاريخ ٣/٨ أحداث سنة إحدى وعشرين من الهجرة، ذكر وقعة نهاوند، وغيرها من المصادر.
٢ - الاستيعاب ٣/١١٠٣ في ترجمة علي بن أبي طالب، أسد الغابة ٤/٢٣ في ترجمة علي بن أبي طالب، الطبقات الكبرى ٢/٣٣٩ في ترجمة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، الإصابة ٤/٤٦٧ في ترجمة علي بن أبي طالب. فتح الباري ١٣/٢٨٦، تهذيب التهذيب ٧/٢٩٦ في ترجمة علي بن أبي طالب، الفصول المهمّة ١/١٩٩ - ٢٠٠ الفصل الأوّل في ذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (كرّم الله وجهه)، فصل في ذكر شيء من علومه (عليه السّلام)، كنز العمّال ١٠/٣٠٠ ح ٢٩٥٠٩، شرح نهج البلاغة ١/١٨، نظم درر السمطين/١٣٢، فيض القدير ٤/٤٧٠ ح ٥٥٩٤، المناقب - للخوارزمي/٩٦، وغيرها من المصادر.
٣ - الاستيعاب ٣/١١٠٣ في ترجمة علي بن أبي طالب، فيض القدير ٤/٤٧٠ ح٥٥٩٤، مسند زيد بن علي/٣٣٥ كتاب الحدود، باب حدّ الزاني، تأويل مختلف الحديث/١٥٢، تفسير السمعاني ٥/١٥٤، الوافي بالوفيات ٢١/١٧٩، الفصول المهمّة ١/١٩٩ الفصل الأوّل في ذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (كرّم الله وجهه)، فصل في ذكر شيء من علومه (عليه السّلام)، المناقب - للخوارزمي/٨١، مطالب السؤول في مناقب آل الرسول/٧٧، ينابيع المودّة ١/٢١٦ و ٢/١٧٢ و ٣/١٤٧، وغيرها من المصادر الكثيرة.
٤ - غاية الأمر أنّه (صلوات الله عليه) كان يقتصر على ما فيه مصلحة الإسلام وتأييده، دون ما كان فيه تأييد لهم بأشخاصهم أو بمراكزهم من دون أن يخدم الإسلام بكيانه العام، إلّا أن يضطر لذلك؛ ولذا امتنع من الخروج مع عمر عندما ذهب إلى الشام حتى شكاه عمر لابن عباس. شرح نهج البلاغة ١٢/٧٨.
ولمّا سُئل عمر عن وجه عدم توليته لأمير المؤمنين (عليه السّلام) وجماعة من الصحابة قال: أمّا علي فأنبه من ذلك.... شرح نهج البلاغة ٩/٢٩.
كما إنّه قد اشترك جماعة من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السّلام) وخواصه في تلك الحروب، كسلمان الفارسي والمقداد بن الأسود الكندي، وحذيفة بن اليمان وعبادة بن الصامت وغيرهم (رضي الله عنهم)، وكان لهم الرأي الصائب والتدبير الحسن والأثر المحمود.
إلاّ أنّ ذلك إنّما يعرفه الخاصّة دون عامّة الناس، ومَنْ عرفه من العامّة نسبه للسلطة، واعتبرهم واجهة له كغيرهم ممّن تعاون معها وسار في ركابها، من دون أن يعرف لهذه الجماعة الصالحة مقامها الرفيع في الإسلام، وجهادها من أجله في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتضحيتها وجهودها في الحفاظ على كيانه ونشره في الأرض بعد ذلك، ولا يحترمها نتيجة ذلك في نفسها.
كما يناسب ذلك ما يأتي من جندب بن عبد الله الأزدي عن موقف أهل الكوفة في أعقاب الشورى من حديثه في بيان مقام أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) وفضله(١) .
وكذلك قول معاوية بن أبي سفيان لعمّار بن ياسر لما بدأ الإنكار من المسلمين على عثمان في مجلس يضم جمعاً من الصحابة: يا عمّار، إنّ بالشام مئة ألف فارس كلّ يأخذ العطاء مع مثلهم من أبنائهم وعبدانهم لا يعرفون علياً وقرابته، ولا عمّاراً ولا سابقته(٢) .
تقييم أمير المؤمنين (عليه السّلام) للأوضاع
وقد أوضح أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) ذلك في حديث له، قال
____________________
١ - يأتي في/٢٥٧ - ٢٥٨.
٢ - الإمامة والسياسة ١/٢٩ ذكر الإنكار على عثمان (رضي الله عنه)، واللفظ له، وقريب منه في تاريخ المدينة ٣/١٠٩٤.
فيه: «إنّ العرب كرهت أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحسدته على ما آتاه الله من فضله، واستطالت أيامه حتى قذفت زوجته، ونفّرت به ناقته، مع عظيم إحسانه إليها، وجسيم مننه عندها، وأجمعت مذ كان حيّاً على صرف الأمر عن أهل بيته.
ولولا أنّ قريشاً جعلت اسمه ذريعة إلى الرياسة، وسُلّماً إلى العزّ والإمرة لما عبدت الله بعد موته يوماً واحداً، ولارتدّت في حافرتها، وعاد قارحها جذعاً، وبازلها بكراً.
ثمّ فتح الله عليها الفتوح فأثرت بعد الفاقة، وتموّلت بعد الجهد والمخمصة؛ فحسن في عيونها من الإسلام ما كان سمجاً، وثبت في قلوب كثير منها من الدين ما كان مضطرباً، وقالت: لولا أنّه حقّ لما كان كذا.
ثمّ نسبت تلك الفتوح إلى آراء ولاتها، وحسن تدبير الأمراء القائمين بها، فتأكّد عند الناس نباهة قوم وخمول آخرين.
فكنّا ممّن خمل ذكره، وخبت ناره، وانقطع صوته وصيته حتى أكل الدهر علينا وشرب، ومضت السنون والأحقاب بما فيها، ومات كثير ممّن يعرف، ونشأ كثير ممّن لا يعرف...»(١) .
وقد قام الولاة ومَنْ دعمهم في سبيل فرض احترامهم، وتوطيد أركان حكمهم، وإضفاء الشرعية عليها، بأمور خطيرة.
استغلال الألقاب المناسبة لشرعية السلطة ونقلها عن أهلها
الأمر الأوّل: إضفاء الألقاب المناسبة لشرعية الحكم ديني، مثل: (خليفة
____________________
١ - شرح نهج البلاغة ٢٠/٢٩٩.
رسول الله)(١) ، و (أمير المؤمنين)، و (ولي رسول الله)(٢) .
وتأكيداً لذلك تختّم عمر وأبو بكر وعثمان بخاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان نقشه: (محمد رسول الله)، وكان يوقّع به في كتبه للأعاجم، أو بما هو مثله في النقش(٣) .
وحُمل أبو بكر(٤) وعمر(٥) بعد موتهما على السرير الذي حُمل عليه رسول
____________________
١ - مسند أحمد ١/١٠، ١٣، ٣٧ مسند أبي بكر الصديق (رضي الله عنه)، المستدرك على الصحيحين ٣/٨١ كتاب معرفة الصحابة، مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)/٦٠٧ ذكر سعد بن الربيع الأنصاري (رضي الله عنه)،. مجمع الزوائد ٥/١٨٤ و ص١٩٨ كتاب الخلافة، باب الخلفاء الأربعة، و باب كيف يدعى الإمام، و٦/٢٢٢ كتاب المغازي والسير، باب قتال أهل الردّة، فتح الباري ١٣/١٧٨، وغيرها من المصادر الكثيرة جدّاً.
٢ - صحيح البخاري ٤/٤٤ باب فرض الخمس، و٥/٢٤ كتاب المغازي، باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهم، و٦/١٩١ كتاب النفقات، و٨/٤ كتاب الفرائض، وص ١٤٧ كتاب الاعتصام بالكتاب والسُنّة، صحيح مسلم ٥/١٥٢ كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء، و٢/٢١ كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مسند أحمد ١/٦٠ مسند عثمان بن عفان (رضي الله عنه)، و ٢٠٨ - ٢٠٩ حديث العباس بن عبد المطلب (رضي الله عنه). وغيرها من المصادر الكثيرة جدّاً.
٣ - صحيح البخاري ٧/٥٣ كتاب اللباس، باب نقش الخاتم، صحيح مسلم ٦/١٥٠ كتاب اللباس والزينة، باب لبس النبي خاتماً من ورق نقشه محمد رسول الله ولبس الخلفاء له من بعده، السنن الكبرى - للبيهقي ٤/١٤٢ كتاب الزكاة، باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلّى به من خاتمه وحلية سيفه ومصحفه إذا كان من فضة، وغيرها من المصادر الكثيرة جدّاً.
٤ - المستدرك على الصحيحين ٣/٦٣ كتاب الهجرة، ذكر مرض أبي بكر ووفاته ودفنه، تاريخ الطبري ٢/٦١٣ أحداث سنة الثالثة عشر من الهجرة، ذكر الخبر عمن غسله والكفن الذي كُفّن فيه أبو بكر (رحمه الله) ومَنْ صلّى عليه والوقت الذي صلّى عليه فيه والوقت الذي توفي فيه (رحمة الله عليه)، الكامل في التاريخ ٢/٤١٩ أحداث سنة الثالثة عشر من الهجرة، ذكر وفاة أبي بكر، وفيات الأعيان ٣/٦٥ في ترجمة أبي بكر الصديق، وغيرها من المصادر.
٥ - أسد الغابة ٤/٧٧ في ترجمة عمر بن الخطاب، تاريخ دمشق ٤٤/٤٥١ في ترجمة عمر بن الخطاب، سبل الهدى والرشاد ١١/٢٧٥، وغيرها من المصادر.
الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما إنّ من المعلوم أنّه دُفن هو وعمر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجرته.
بل تمادت السلطة وأتباعها فوصفوا الحاكم بأنّه (خليفة الله)(١) ، و (سلطان الله في الأرض)(٢) ، ونحو ذلك.
وقد روى راشد بن سعد أنّ عمر أتي بمال فجعل يقسّم بين الناس، فازدحموا عليه، فأقبل سعد بن أبي وقّاص يزاحم الناس حتى خلص إليه، فعلاه عمر بالدرّة، قال: إنّك أقبلت لا تهاب سلطان الله في الأرض، فأحببت أن أعلمك أنّ سلطان الله لن يهابك(٣) .
وفي كتاب عثمان إلى الأمراء يتحدّث عن الجماعة المحاصرين له قالوا: لا نرضى إلّا بأن تعتزلنا، وهيهات لهم والله من أمر ينال به الشيطان فيما بعد اليوم من سلطان الله حاجته....
ولما قدم الكتاب عليهم قام معاوية فخطب الناس وكان فيما قال: انهضوا إلى سلطان الله فأعزوه يعزكم وينصركم....
وخطب أبو موسى فكان فيما قال: وإنّما قوام هذا الدين السلطان، بادروا
____________________
١ - أنساب الأشراف ٥/٢٧ وأمّا معاوية بن أبي سفيان، مروج الذهب ٣/٥٣ ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان، موقف آخر بين صعصعة ومعاوية، تاريخ دمشق ٣٩/٥٤٣ في ترجمة عثمان بن عفان و٤٠/٤١١ في ترجمة عطاء بن أبي صيفي بن نضلة، و٧٠/٧٢ في ترجمة ليلي الأخليلية، الفتوح - لابن أعثم ٣/٨٨ بعد حديث الزرقاء بنت عدي الهمذانية مع معاوية، وغيرها من المصادر.
٢ - تاريخ الطبري ٦/٣٣١ أحداث سنة ١٥٨ من الهجرة، ذكر الخبر عن صفة أبي جعفر المنصور وذكر بعض سيره، البداية والنهاية ١٠/١٣٠ أحداث سنة ١٥٨ من الهجرة، ترجمة المنصور، تاريخ دمشق ٣٢/٣١١ في ترجمة عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، وغيرها من المصادر.
٣ - الطبقات الكبرى ٣/٢٨٧ ذكر استخلاف عمر، واللفظ له، تاريخ الطبري ٣/٢٨٠ أحداث سنة ثلاث وعشرين من الهجرة، ذكر الخبر عن مقتل عمر (رضي الله عنه)، حمله الدرّة وتدوينه الدواوين، أنساب الأشراف ١٠/٣٣٨ - ٣٣٩ نسب بني عدي بن كعب بن لؤي، في ترجمة عمر بن الخطاب، كنز العمّال ١٢/٥٦٤ ح ٣٥٧٦٨، شرح نهج البلاغة ١٢/٩٦.
سلطان الله لا يُستذل...(١) .
وأخذ عبد الله بن سلام ينهى المحاصرين لعثمان عن قتله، وكان فيما قال:... ويلكم إنّ سلطان الله اليوم يقوم بالدرّة، وإن قتلتموه لم يقم إلّا بالسيف(٢) .
وقال معاوية في خلافته: الأرض لله، وأنا خليفة الله، فما أخذت فلي، وما تركته للناس فبفضل منّي(٣) .
وقال جويرية بن أسماء: قدم أبو موسى الأشعري على معاوية في برنس أسود، فقال: السّلام عليك يا أمين الله. قال: وعليك السّلام. فلمّا خرج قال معاوية: قدم الشيخ لأولّيه، والله لا أولّيه(٤) .
وخطب زياد بن أبيه فقال في جملة ما قال: أيّها الناس، إنّا أصبحنا لكم ساسة، وعنكم ذادة، نسوسكم بسلطان الله الذي أعطانا، ونذود عنكم بفيء الله الذي خوّلنا، فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحببنا...(٥) .
____________________
١ - تاريخ دمشق ٣٩/٤٣١ في ترجمة عثمان بن عفان.
٢ - تاريخ دمشق ٣٩/٤٣٩ في ترجمة عثمان بن عفان.
٣ - أنساب الأشراف ٥/٢٧ وأمّا معاوية بن أبي سفيان، واللفظ له، مروج الذهب ٣/٥٣ ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان، موقف آخر بين صعصعة ومعاوية، نثر الدرّ ٢/١٤٢ الباب السابع، الجوابات المسكتة الحاضرة، التذكرة الحمدونية ٢/٣٤١ الباب الثالث والثلاثون، في الحجج البالغة والأجوبة الدامغة، وغيرها من المصادر.
٤ - الكامل في التاريخ ٤/١٢ أحداث سنة ستين من الهجرة عند الكلام عن معاوية بن أبي سفيان، ذكر بعض سيرته وأخباره وقضاته وكتابه، واللفظ له، تاريخ الطبري ٤/٢٤٥ أحداث سنة ستين من الهجرة عند الكلام عن معاوية بن أبي سفيان، ذكر بعض أخباره وسيره.
٥ - الكامل في التاريخ ٣/٤٤٩ أحداث سنة خمس وأربعين من الهجرة، ذكر ولاية زياد بن أبيه البصرة، واللفظ له، تاريخ الطبري ٤/١٦٦ أحداث سنة خمس وأربعين من الهجرة، ذكر الخبر عن ولاية زياد البصرة، الفتوح - لابن أعثم ٤/٣٠٧ ذكر خطبة زياد بالبصرة، شرح نهج البلاغة ١٦/٢٠٢.
وفي كتاب الوليد بن يزيد بن عبد الملك إلى رعيته بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فأبان الله به الهدى...، ثمّ استخلف خلفاءه على منهاج نبوّته حين قبض نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم...، فتتابع خلفاء الله على ما أورثهم الله عليه من أمر أنبيائه، واستخلفهم عليه منه، لا يتعرض لحقّهم أحد إلّا صرعه الله، ولا يُفارق جماعتهم أحد إلّا أهلكه الله...، وكذلك صنع الله ممّن فارق الطاعة التي أمر بلزومها والأخذ بها...، فبالخلافة أبقى الله مَنْ أبقى في الأرض من عباده، وإليها صيّره، وبطاعة مَنْ ولاّه إيّاها سَعُد مَنْ أكرمها ونصرها...، فمَنْ أخذ بحظّه منها كان لله ولي، ولأمره مطيع...، ومَنْ تركها ورغب عنها وحادّ الله فيها أضاع نصيبه، وعصى ربّه، وخسر دنياه وآخرته...، والطاعة رأس هذا الأمر وذروته، وسنامه وزمامه، وملاكه وعصمته وقوامه بعد كلمة الإخلاص لله التي ميّز بها بين العباد... إلى آخر ما في هذا الكتاب ممّا يجري مجرى ذلك(١) .
عدم شرعية استغلال السلطة لهذه الألقاب
مع إنّ من المعلوم أنّ نظام الحكم عند رموز الجمهور يبتني على عدم النصّ من الله (عزّ وجلّ)، ولا من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على شخص الحاكم، أو تحديده بنحو منضبط؛ بحيث يتعيّن في شخص خاص، ليتّجه نسبة الخليفة لله (عزّ وجلّ) أو لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإضافته لهما.
وقد أشار إلى ذلك العباس بن عبد المطلب في جوابه لأبي بكر في حديث بينهما طويل، حينما عرض عليه أبو بكر أن يجعل له ولعقبه من بعده نصيباً في الخلافة من أجل أن يقطعه عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) ويضعف حجّته، حيث قال العباس له في جملة ما قال: وما أبعد تسميتك بخليفة رسول الله من قولك: خلى
____________________
١ - تاريخ الطبري ٥/٥٣٠ أحداث سنة ١٢٥ من الهجرة، خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك.
على الناس أمورهم ليختاروا فاختاروك!(١) .
ولمّا أرسلوا لأمير المؤمنين (صلوات الله عليه) يطلبون منه أن يحضر ليبايع أبا بكر، وقيل له: خليفة رسول الله يدعوك. قال (عليه السّلام): «لسريع ما كذبتم على رسول الله»(٢) .
اختصاص لقب أمير المؤمنين بالإمام علي (عليه السّلام)
كما إنّ لقب (أمير المؤمنين) من مختصّات الإمام علي (صلوات الله عليه) على ما ورد عن أئمّة أهل البيت (صلوات الله عليهم) فيما رواه عنهم شيعتهم(٣) ، وحتى بعض الجمهور(٤) ، بل في بعض روايات الجمهور أنّه اسم سمّاه به جبرئيل، كما سمّاه الله (عزّ وجلّ) به(٥) ، وأنّه ينادى به يوم القيامة(٦) .
وورد أيضاً أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أطلقه عليه في عدّة مواضع(٧) . بل
____________________
١ - تاريخ اليعقوبي ٢/١٢٥ خبر سقيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكر.
٢ - الإمامة والسياسة ١/١٦ كيف كانت بيعة علي بن أبي طالب (كرّم الله وجهه)، واللفظ له، كتاب سليم بن قيس/٣٨٥، الاختصاص/١٨٥، الاحتجاج ١/١٠٨.
٣ - الكافي ١/٤١١ و٤٤٣، الخصال/٥٨٠، الاختصاص/٥٤، الأمالي - للطوسي/٢٩٥، اليقين - لابن طاووس/٢٧، تفسير العياشي ١/٢٧٦، دلائل الإمامة/٥٣، فضائل أمير المؤمنين (عليه السّلام) - لابن عقدة/٦٠، وغيرها من المصادر.
٤ - المناقب - للخوارزمي/٣٠٣ الفصل التاسع عشر في فضائل له شتى.
٥ - المناقب - للخوارزمي/٣٢٣ الفصل التاسع عشر في فضائل له شتى.
٦ - المناقب - للخوارزمي/٣٥٩ - ٣٦٠ الفصل الثاني والعشرون في بيان أنّه حامل لوائه يوم القيامة، تاريخ دمشق ٤٢/٣٢٦ - ٣٢٨ في ترجمة علي بن أبي طالب، تاريخ بغداد ١٣/١٢٤ في ترجمة المفضل بن سلم، ينابيع المودّة ١/٢٣٨.
٧ - تاريخ دمشق ٤٢/٣٠٣، ٣٢٦، ٣٢٨، ٣٨٦ في ترجمة علي بن أبي طالب، المناقب - للخوارزمي/٨٥ الفصل السابع في بيان غزارة علمه وأنّه أقضى الأصحاب، وص ١٤٢ الفصل الرابع عشر في بيان أنّه أقرب الناس من رسول الله وأنّه مولى مَنْ كان رسول الله مولاه، موضح أوهام الجمع والتفريق ١/١٨٥، تاريخ بغداد ١٣/١٢٤ في ترجمة المفضل بن سلم، الفردوس بمأثور الخطاب =
في حديث بريدة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نُسلّم على علي بأمير المؤمنين، ونحن سبعة، وأنا أصغر القوم يومئذٍ(١) .
ولذا ورد عن أبي ذرّ (رضي الله عنه) أنّه حينما مرض أوصى لأمير المؤمنين علي (صلوات الله عليه)، فقيل له: لو أوصيت إلى أمير المؤمنين عمر لكان أجمل لوصيتك من علي. فقال: والله، لقد أوصيت إلى أمير المؤمنين حقاً، وإنّه والله أمير المؤمنين...(٢) .
ونحوه ما رواه ابن مردويه بسنده عن معاوية بن ثعلبة قال: دخلنا على أبي ذرّ (رضي الله عنه) نعوده في مرضه الذي مات فيه، فقلنا: أوصِ يا أبا ذرّ. قال: قد أوصيت إلى أمير المؤمنين. قال: قلنا: عثمان؟ قال: لا، ولكن إلى أمير المؤمنين حقاً، أمير المؤمنين والله، إنّه لَرِبيّ الأرض، وإنّه لَرَباني هذه الأُمّة...(٣) .
وعن أبي شريح، أنّه قال: أتى حذيفة بالمدائن ونحن عنده أنّ الحسن
____________________
= ٥/٣٦٤، حلية الأولياء ١/٦٣ في ترجمة علي بن أبي طالب، لسان الميزان ١/١٠٧ في ترجمة إبراهيم بن محمد بن ميمون، ميزان الاعتدال ١/٦٤ في ترجمة إبراهيم بن محمود بن ميمون، مطالب السؤول/١٢٦، الكافي ١/٢٩٢، تفسير القمي ١/١٧٤، المسترشد/٥٨٤، الإرشاد/١٩، الاحتجاج ١/٨٣، اليقين - لابن طاووس/٢٨٥، مناقب آل أبي طالب - لابن شهرآشوب ٢/٢٥٢، وغيرها من المصادر الكثيرة.
١ - تاريخ دمشق ٤٢/٣٠٣ في ترجمة علي بن أبي طالب، واللفظ له، الإرشاد ١/٤٨، اليقين - لابن طاووس/٢٢٩، ونحوه في الخصال/٤٦٤، وعيون أخبار الرضا ١/٧٣، والمسترشد/٥٨٦، والأمالي - للطوسي/٣٣١، والتحصين/٥٧٥، وكشف الغمة ١/٣٥١، وغيرها من المصادر.
٢ - شرح إحقاق الحق ٨/٦٧٩ نقلاً عن مناقب عبد الله الشافعي/٨٧، واللفظ له، كتاب سليم بن قيس/٢٦٨، كشف الغمة ١/٣٥٣ ذكر الإمام علي بن أبي طالب (عليه السّلام)، مخاطبته بأمير المؤمنين، الشافي في الإمامة ٣/٢٢٤، اليقين - لابن طاووس/١٤٥، وغيرها من المصادر.
٣ - اليقين - لابن طاووس/١٤٦، واللفظ له، الإرشاد ١/٤٧، كتاب سليم بن قيس/٢٧١، نهج الإيمان - لابن جبر/٤٦٢، وغيرها من المصادر.
وعمّاراً قدما الكوفة يستنفران الناس إلى علي، فقال حذيفة: إنّ الحسن وعمّاراً قدما يستنفرانكم، فمَنْ أحبّ أن يلقى أمير المؤمنين حقّاً حقّاً فليأتِ إلى علي بن أبي طالب(١) .
وعن حذيفة أيضاً أنّه لما كتب إليه أمير المؤمنين (عليه السّلام)، وأقرّه على عمله بالمدائن بعد قتل عثمان، قام خطيباً في الناس، وقال في جملة ما قال: أيّها الناس، إنّما وليّكم الله ورسوله وأمير المؤمنين حقّاً حقّاً، وخير مَنْ نعلمه بعد نبيّنا...(٢) .
تحجير السلطة على السُنّة النبويّة
الأمر الثاني ممّا قام به الولاة في سبيل دعم سلطانهم: التحجير على السُنّة النبويّة، بمنع تدوينها(٣) ، وحرق ما دوّن منها(٤) ، ومنع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلّا بما يتناسب مع نهج الحاكم ورغبته حتى حبس عمر عبد الله بن مسعود وأبا ذرّ(٥) ، الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حقّه: «ما أظلّت الخضراء، ولا
____________________
١ - أنساب الأشراف ٢/٣٦٦ (وأمّا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السّلام»، واللفظ له، ونحوه في ٣/١٧ في بيعة علي بن أبي طالب (عليه السّلام).
٢ - بحار الأنوار ٢٨/٨٩.
٣ - جامع بيان العلم وفضله ١/٦٥ باب ذكر كراهية كتابة العلم وتخليده في الصحف، كنز العمّال ١٠/٢٩٢ ح٢٩٤٧٦.
٤ - تذكرة الحفاظ ١/٥ في ترجمة أبي بكر الصديق (رضي الله تعالى عنه)، كنز العمّال ١٠/٢٨٥ ح٢٩٤٦٠، الطبقات الكبرى ٥/١٨٨ في ترجمة القاسم بن محمد، تاريخ الإسلام ٧/٢٢٠ - ٢٢١ في ترجم القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.
٥ - تذكرة الحفاظ ١/٧ في ترجمة عمر بن الخطاب، المجروحين - لابن حبان ١/٣٥ ذكر أوّل مَنْ وقى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المستدرك على الصحيحين ١/١١٠ كتاب العلم، حبس عمر (رضي الله عنه) ابن مسعود (رضي الله عنه) وغيره على كثرة الرواية، سير أعلام النبلاء ٢/٣٤٦ في ترجمة أبي الدرداء، تاريخ دمشق ٤٧/١٤٢ في ترجمة عويمر بن زيد بن قيس، المصنّف - لابن أبي شيبة ٦/٢٠١ في هيبة =
أقلّت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذرّ»(١) .
وعن عبد الرحمن بن عوف أنّه قال: والله، ما مات عمر حتى بعث إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجمعهم من الآفاق: عبد الله وحذيفة وأبي الدرداء وأبي ذرّ وعقبة بن عامر، فقال: ما هذه الأحاديث التي أفشيتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الآفاق؟! فقالوا: أتنهانا؟ قال: لا، أقيموا عندي، لا والله، لا تُفارقوني ما عشت، فنحن أعلم ما نأخذ ونردّ عليكم(٢) .
قسوة السلطة في تنفيذ مشروعها
ويبدو من بعض الروايات أنّ الأمر بلغ من الشدّة حدّاً كُمّت معه الأفواه. ففي حديث حذيفة: «كنّا مع رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) فقال: أحصوا لي كم يلفظ الإسلام. قال: فقلنا: يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة؟! قال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منّا لا يصلى إلا سراً»(٣) ولعل منه حديث مطرف قال: بعث إليّ عمران بن حصين في مرضه
____________________
= الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنّه لم يذكر أبا ذرّ، وغيرها من المصادر.
١ - مسند أحمد ٥/١٩٧ باقي حديث أبي الدرداء، واللفظ له، و٢/٢٢٣ مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، و٦/٤٤٢ من حديث أبي الدرداء عويم (رضي الله عنه)، سنن الترمذي ٥/٣٣٤ أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مناقب أبي ذرّ الغفاري (رضي الله عنه)، المستدرك على الصحيحين ٣/٣٤٢ - ٣٤٤ كتاب معرفة الصحابة، ذكر مناقب أبي ذرّ الغفاري (رضي الله عنه)، صحيح ابن حبان ١٦/٧٦ كتاب إخباره صلى الله عليه وآله وسلم عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم، مناقب أبي ذرّ الغفاري (رضي الله عنه)، مجمع الزوائد ٩/٣٢٩ كتاب المناقب، باب في أبي ذرّ (رضي الله عنه)، المصنّف - لابن أبي شيبة ٧/٥٢٦ كتاب الفضائل، ما جاء في أبي ذرّ الغفاري (رضي الله عنه)، وغيرها من المصادر الكثيرة جدّاً.
٢ - تاريخ دمشق ٤٠/٥٠٠ - ٥٠١ في ترجمة عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو، واللفظ له، كنز العمّال ١٠/٢٩٣ ح٢٩٤٧٩.
٣ - صحيح مسلم ج: ١ ص: ٩١ كتاب الإيمان: باب الاستسرار بالإيمان للخائف، واللفظ له. مسند أحمد ج: ٥ ص: ٣٨٤ حديث حذيفة بن اليمان. سنن ابن ماجة ج: ٢ ص: ١٣٣٧ كتاب الفتن: باب الصبر على =
الذي توفي فيه، فقال: إنّي كنت محدّثك بأحاديث، لعلّ الله أن ينفعك بها بعدي؛ فإن عشت فاكتم عنّي، وإن متّ فحدّث بها إن شئت، إنّه قد سلم عليّ إنّ نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قد جمع بين حجّة وعمرة، ثمّ لم ينزل بها كتاب، ولم ينه عنها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال رجل فيها برأيه ما شاء(١) .
بل يبدو إنّ الأمر تجاوز ذلك إلى منع العلم والثقافة إلّا ما بذلته السلطة بحيث لا يحقّ لأحد أن يطلب العلم ويسأل إلّا في حدود خاصة، ومَنْ حاول ما خرج عن ذلك لا يقتصر على منعه، بل يُنهك عقوبة ونكالاً؛ ليكون عبرة لغيره، فلا يتجرّأ على البحث والسؤال.
فقد تظافرت النصوص أنّ صبيغاً سأل عن متشابه القرآن فعزّره عمر(٢) ، بل في بعضها أنّه أنهكه عقوبة وأضرّ به(٣) . وفي بعضها أنّه منع المسلمين
____________________
= البلاء. السنن الكبرى للنسائي ج: ٥ ص: ٢٧٦ كتاب السير: إحصاء الإمام الناس. صحيح ابن حبان ج: ١٤ ص: ١٧١ كتاب التاريخ: ذكر إحصاء المصطفى (صلّى الله عليه وآله وسلم) من كان تلفظ بالإسلام في أول الإسلام. المصنف لابن أبي شيبة ج: ٨ ص: ٦١٩ كتاب الفتن: باب من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها. وغيرها من المصادر الكثيرة جداً.
١ - صحيح مسلم ٤/٤٨ كتاب الحجّ، باب جواز التمتّع، واللفظ له، الطبقات الكبرى ٤/٢٩٠ في ترجمة عمران بن حصين، سنن الدارمي ٢/٣٥ كتاب المناسك، باب في القران، مسند أحمد ٤/٤٢٨ حديث عمران بن حصين (رضي الله عنه)، أضواء البيان ٤/٣٦٦، وغيرها من المصادر.
٢ - سنن الدارمي ١/٥٤ باب مَنْ هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع، الإصابة ٣/٣٧٠ في ترجمة صبيغ بن عسل، تاريخ دمشق ٢٣/٤١١ في ترجمة صبيغ بن عسل، الاستذكار لابن عبد البر ٥/٧٠، نصب الراية ٤/١١٨، تفسير القرطبي ٤/١٥، الدرّ المنثور ٢/٧، فتح القدير ١/٣١٩، الاتقان في علوم القرآن ٢/٩، تخريج الأحاديث والآثار - للزيلعي ٣/٣٦٥، كنز العمّال ٢/٣٣٤ ح ٤١٧٠، وغيرها من المصادر الكثيرة.
٣ - سنن الدارمي ١/٥٤ باب مَنْ هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع، تاريخ دمشق ٢٣/٤١٠ - ٤١١ في ترجمة صبيغ بن عسل، تفسير القرآن - لعبد الرزاق ٢/٢٤٩، تفسير القرطبي ٩/٢٢٦، تفسير ابن كثير ٢/٢٩٤، الدرّ المنثور ٦/١١١، الاستذكار - لابن عبد البر ٥/٧٠، كنز العمّال ٢/٣٣١ ح ٤١٦١، وص٣٣٥ ح ٤١٧٢، وغيرها من المصادر. =
من مجالسته(١) ، ومن عيادته إذا مرض(٢) ، وحرمه عطاءه ورزقه(٣) .
وعن بعضهم قال: رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنّه بعير أجرب يجيء إلى الحلقة ويجلس وهم لا يعرفونه، فتناديهم الحلقة الأخرى: عزمة أمير المؤمنين عمر، فيقومون ويدعونه(٤) .
سيرة عمر أيّام ولايته
وذلك يناسب ما هو المعلوم من شدّة عمر وسطوته.
كما أجاب بذلك عبد الرحمن بن عوف أبا بكر لما سأله عنه، حيث قال له: إنّه أفضل من رأيك، إلّا إنّ فيه غلظة(٥) . بل أنكر بعض المهاجرين على أبي
____________________
= قال نافع مولى عبد الله: إنّ صبيغ العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن... فأرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى نزل ظهره دبرة ثمّ تركه حتى برأ ثمّ عاد له ثمّ تركه حتى برأ فدعا به ليعود، فقال صبيغ: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلاً جميلاً، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برأت....
١ - سنن الدارمي ١/٥٤ باب مَنْ هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع، المصنّف - لعبد الرزاق ١١/٤٢٦ باب مَنْ حالت شفاعته دون حدّ، الإصابة ٣/٤٧١ في ترجمة صبيغ. تاريخ دمشق ٢٣/٤٠٨ - ٤١٣ في ترجمة صبيغ بن عسل، تفسير ابن كثير ٤/٢٤٨، الدرّ المنثور ٦/١١١، الاتقان في علوم القرآن ٢/٩، إكمال الكمال ٦/٢٠٧ باب عسل، كنز العمّال ٢/٣٣١ ح ٤١٦١، وص ٣٣٥ ح ٤١٧٣، ٤١٧٤، وص ٥١٠ ح ٤٦١٧، وص ٥١١ ح ٤٦١٨، و١١/٢٩٧ ح ٣١٥٥٩، وغيرها من المصادر.
٢ - الدرّ المنثور ٢/٧، كنز العمّال ٢/٣٣٧ ح ٤١٨٠.
٣ - الإصابة ٣/٣٧١ في ترجمة صبيغ، تاريخ دمشق ٢٣/٤١٣ في ترجمة صبيغ بن عسل، الوافي بالوفيات ١٦/١٦٣ في ترجمة صبيغ اليربوعي، الفقيه والمتفقه ٢/١٩، الدرّ المنثور ٢/٧، كنز العمّال ٢/٣٣٥ ح ٤١٧٤، وغيرها من المصادر.
٤ - تاريخ دمشق ٢٣/٤١٣ في ترجمة صبيغ بن عسل، واللفظ له، الاستذكار - لابن عبد البر ٥/٧٠، الدرّ المنثور ٢/٧، وغيرها من المصادر.
٥ - شرح نهج البلاغة ١/١٦٤.
بكر استخلافه لعمر، حيث قال له: استخلفت علينا عمر وقد عَتا علينا ولا سلطان له، فلو قد ملكنا كان أعتا وأعتا، فكيف تقول لله إذا لقيته؟!(١) .
وتقول أسماء بنت عميس: دخل طلحة بن عبيد الله على أبي بكر، فقال: استخلفت على الناس عمر، وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه، فكيف به إذا خلا بهم؟! وأنت لاقٍ ربّك فسائلك عن رعيّتك. فقال أبو بكر وكان مضطجعاً: أجلسوني. فأجلسوه. فقال لطلحة: أبالله تفرّقني؟! أو أبالله تخوّفني؟! إذا لقيت الله ربّي فساءلني قلت: استخلفت على أهلك خير أهلك(٢) .
وزاد ابن أبي الحديد: فقال طلحة: أعمر خير الناس يا خليفة رسول الله؟! فاشتدّ غضبه، فقال: إي والله هو خيرهم، وأنت شرّهم. أما والله لو وليّتك لجعلت أنفك في قفاك، ولرفعت نفسك فوق قدرها حتى يكون الله هو الذي يضعه، أتيتني وقد دلكت عينك تريد أن تفتنني عن ديني وتزيلني عن رأيي؟! قم لا أقام الله رجليك... فقام طلحة فخرج(٣) .
وفي رواية أخرى أنّ طلحة قال له: ما أنت قائل لربّك غداً وقد ولّيت علينا فظّاً غليظاً تُفرّق منه النفوس، وتنفضّ عنه القلوب؟!(٤) .
بل قال ابن قتيبة: فدخل عليه المهاجرون والأنصار حين بلغهم أنّه استخلف عمر، فقالوا: نراك استخلفت علينا عمر وقد عرفته وعلمت
____________________
١ - تاريخ دمشق ٤٤/٢٤٩ - ٢٥٠ في ترجمة عمر بن الخطاب، واللفظ له، الفائق في غريب الحديث ١/٨٩.
٢ - تاريخ الطبري ٢/٦٢١ أحداث سنة ثلاث عشرة من الهجرة، ذكر أسماء قضاته وكتابه وعمّاله على الصدقات، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٢/٤٢٥ أحداث سنة ثلاث عشرة من الهجرة، ذكر استخلافه عمر بن الخطاب، شرح نهج البلاغة ١/١٦٤ - ١٦٥، وقريب منه في الفتوح - لابن أعثم ١/١٢١ ذكر وفاة أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) قبل فتح دمشق.
٣ - شرح نهج البلاغة ١/١٦٥.
٤ - شرح نهج البلاغة ١/١٦٤.
بوائقه(١) فينا وأنت بين أظهرنا، فكيف إذا ولّيت عنّا؟ وأنت لاقٍ الله (عزّ وجلّ) فسائلك، فما أنت قائل؟ فقال أبو بكر: لئن سألني الله لأقولنّ: استخلفت عليهم خيرهم في نفسي... وكان أهل الشام قد بلغهم مرض أبي بكر استبطؤوا الخبر، فقالوا: إنّا لنخاف أن يكون خليفة رسول الله قد مات وولي بعده عمر، فإن كان عمر هو الوالي فليس لنا بصاحب، وإنّا لنرى خلعه(٢) .
وعن زيد بن الحارث أنّ أبا بكر حين حضره الموت أرسل إلى عمر يستخلفه فقال الناس: تستخلف علينا فظّاً غليظاً، ولو قد ولينا كان أفظّ وأغلظ، فما تقول لربّك إذا لقيته وقد استخلفت عمر؟!(٣) .
ويظهر من ذلك أنّ المنكرون لولاية عمر في أنفسهم وعلى أبي بكر جماعة كثيرون، ويناسبه قول أبي بكر لعبد الرحمن بن عوف: إنّي ولّيت أمركم خيركم في نفسي، فكلّكم ورم أنفه من ذلك يريد أن يكون الأمر له دونه...(٤) .
وعن سيرة عمر في ولايته وسلطانه يقول أمير المؤمنين (صلوات الله
____________________
١ - هكذا وردت في طبعة مؤسسة الحلبي وشركائه بتحقيق الدكتور طه محمد الزيني، وكذا طبعة أمير - قم سنة ١٤١٣هـ بتحقيق علي شيري، وأمّا ما في طبعة دار الكتب العلمية في بيروت سنة ١٤١٨هـ/١٩٩٧م بتعليق خليل المنصور فالوارد هكذا: (بوائقه).
٢ - الإمامة والسياسة ١/٢٣ ولاية عمر بن الخطاب (رضي الله عنه).
٣ - المصنّف - لابن أبي شيبة ٨/٥٧٤ كتاب المغازي، ما جاء في خلافة عمر بن الخطاب، واللفظ له، تاريخ المدينة ٢/٦٧١، كنز العمّال ٥/٦٧٨ ح ١٤١٧٨.
٤ - تاريخ الطبري ٢/٦١٩ أحداث سنة ثلاث عشرة من الهجرة، ذكر أسماء قضاته وكتابه وعمّاله على الصدقات، واللفظ له، مجمع الزوائد ٥/٢٠٢ كتاب الخلافة، باب كراهة الولاية ولمَنْ تستحب، المعجم الكبير ١/٦٢ وممّا أسند أبو بكر الصديق (رضي الله تعالى عنه) عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الإمامة والسياسة ١/٢٠ مرض أبي بكر واستخلافه عمر (رضي الله عنهم)، تاريخ دمشق ٣٠/٤٢٠ في ترجمة أبي بكر الصديق، ميزان الاعتدال ٣/١٠٩ في ترجمة علوان بن داود البجلي، لسان الميزان ٤/١٨٨ في ترجمة علوان بن داود البجلي، وقد ذكر بعضه في النهاية في غريب الحديث ٥/١٧٧، ولسان العرب ٩/١٥، وتاج العروس ١٧/٧٢٣، وغيرها من المصادر.
عليه) في خطبته الشقشقية: «فصيّرها في حوزة خشناء يغلظ كلامها، ويخشن مسّها، ويكثر العثار فيها، والاعتذار منها. فصاحبها كراكب الصعبة، إن أشنق لها خرم، وإن أسلس لها تقحّم؛ فمُنِيَ الناس - لعمرو الله - بخبطٍ وشماس، وتلوّن واعتراض، فصبرت على طول المدّة وشدّة المحنة»(١) .
ويقول عثمان: أما والله يا معشر المهاجرين والأنصار، لقد عبتم عليّ أشياء ونقمتم أموراً قد أقررتم لابن الخطاب مثلها، ولكنّه وَقَمَكم(٢) وقمعكم، ولم يجترئ أحد يملأ بصره منه، ولا يشير بطرفه إليه...(٣) .
وعن المغيرة أنّه قال: كان ممّا تميّز به عمر (رضي الله عنه) الرعب، إنّ الناس كانوا يفرقونه(٤) .
وقال الأصمعي: كلّم الناس عبد الرحمن بن عوف أنّ يكلّم عمر بن الخطاب أن يلين لهم؛ فإنّه قد أخافهم حتى إنّه قد أخاف الأبكار في خدورهنّ. فقال عمر: إنّي لا أجد لهم إلّا ذلك، وإنّهم لو يعلمون ما لهم عندي لأخذوا ثوبي عن عاتقي(٥) .
____________________
١ - نهج البلاغة ١/٣٣، واللفظ له، علل الشرائع ١/١٥١، معاني الأخبار/٣٦١، مناقب آل أبي طالب - لابن شهرآشوب ٢/٤٩، وغيرها من المصادر.
٢ - وقم الدابة: جذب عنانها لتقف. ووقم الرجل َ: قهره وردّه عن حاجته أقبح الردّ.
٣ - الإمامة والسياسة ١/٢٨ ذكر الإنكار على عثمان (رضي الله عنه)، واللفظ له، تاريخ الطبري ٣/٣٧٧ أحداث سنة أربع وثلاثين من الهجرة، تكاتب المنحرفين عن عثمان للاجتماع...، الكامل في التاريخ ٣/١٥٢ أحداث سنة أربع وثلاثين من الهجرة، ذكر ابتداء قتل عثمان، البداية والنهاية ٧/١٨٩ أحداث سنة أربع وثلاثين من الهجرة، إعجاز القرآن - للباقلاني/١٤٢، شرح نهج البلاغة ٩/٢٣، وغيرها من المصادر.
٤ - تاريخ المدينة ٢/٦٨ هيبة عمر.
٥ - عيون الأخبار ١/١٢ كتاب السلطان، واللفظ له، تاريخ دمشق ٤٤/٢٦٩ - ٢٧٠ في ترجمة عمر بن الخطاب، كنز العمّال ١٢/٦٥٠ - ٦٥١ ح ٣٥٩٧٩، التذكرة الحمدونية ١/١٠٩ الفصل الخامس أخبار في السياسة والآداب.
وفي حديث محمد بن زيد أنّ جماعة من المهاجرين قالوا لعبد الرحمن: لو أنّك كلّمت أمير المؤمنين؛ فإنّه يقدم الرجل فيطلب الحاجة فتمنعه مهابته أن يكلّمه حتى يرجع، فليلن للناس(١) .
ويبدو الإغراق في الشدّة والإرعاب ممّا عن القاسم بن محمد قال: بينما عمر (رضي الله عنه) يمشي وخلفه عدّة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم بدا له فالتفت فما بقي منهم أحد إلّا سقط إلى الأرض على ركبتيه، فلما رأى ذلك بكى، ثمّ رفع يديه فقال: اللّهمّ إنّك تعلم أنّي منك منهم أشدّ فرقاً منهم منّي(٢) ... إلى غير ذلك ممّا يجده الناظر في سيرته. ويأتي بعض ما يتعلّق بذلك في المقام الأوّل من المبحث الثاني إن شاء الله تعالى.
هذا والحديث في التحجير على السُنّة النبويّة طويل تعرّضنا لطرفٍ منه في جواب السؤال السابع من الجزء الأوّل من كتابنا (في رحاب العقيدة)، وعند التعرّض لمحن الحديث النبوي الشريف في أواخر جواب السؤال الثامن من الجزء الثالث من الكتاب المذكور.
وضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصالح السلطة
كما يبدو أنّ التحجير المذكور قد قارن أمراً لا يقلّ خطورة عنه، بل قد يكون أخطر منه، وهو قيام السلطة بالتعاون مع حديثي الإسلام والمنافقين الذين قرّبتهم - كما يأتي - بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما يتناسب مع رغبتها، ويرفع من شأنها وشأن المتعاونين معها.
____________________
١ - تاريخ المدينة ٢/٦٨١ هيبة عمر، واللفظ له، الطبقات الكبرى ٣/٢٨٧ ذكر استخلاف عمر (رضي الله عنه)، تاريخ دمشق ٤٤/٢٦٩ في ترجمة عمر بن الخطاب، كنز العمّال ١٢/٥٦٤ ح ٣٥٧٧٠.
٢ - تاريخ المدينة ٢/٦٨١ هيبة عمر.
كلام أمير المؤمنين (عليه السّلام) في أسباب اختلاف الحديث
فقد روي بطرق متعدّدة عن سليم بن قيس الهلالي، قال: قلت لأمير المؤمنين (عليه السّلام): إنّي سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذرّ أشياء من تفسير القرآن، وأحاديث عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم غير ما في أيدي الناس، ثمّ سمعت منك تصديق ما سمعت منهم، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أنتم تخالفونهم فيها، وتزعمون أنّ ذلك كلّه باطل. أفترى الناس يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متعمّدين، ويفسّرون القرآن بآرائهم؟
قال: فأقبل عليّ فقال: «قد سألت فافهم الجواب. إنّ في أيدي الناس حقّاً وباطلاً، وصدقاً وكذباً، وناسخاً ومنسوخاً، وعامّاً وخاصّاً، ومحكماً ومتشابهاً، وحفظاً ووهماً، وقد كُذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عهده حتى قام خطيباً، فقال: أيّها الناس، قد كثرت عليّ الكذّابة، فمَنْ كذب عليّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار، ثمّ كُذب عليه من بعده.
وإنّما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس:
رجل منافق: يظهر الإيمان، متصنّع بالإسلام، لا يتأثم ولا يتحرّج أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متعمّداً. فلو علم الناس أنّه منافق كذّاب لم يقبلوا منه ولم يصدّقوه، ولكنّهم قالوا: هذا قد صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورآه وسمع منه. وأخذوا عنه وهم لا يعرفون حاله.
وقد أخبره الله عن المنافقين بما أخبره، ووصفهم بما وصفهم، فقال (عزّ وجلّ):( وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ) .
ثمّ بقوا بعده، فتقرّبوا إلى أئمّة الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والكذب
والبهتان، فولّوهم الأعمال، وحملوهم على رقاب الناس، وأكلوا بهم الدنيا، وإنّما الناس مع الملوك والدنيا إلّا مَنْ عصم الله، فهذا أحد الأربعة.
ورجل سمع من رسول الله شيئاً لم يحمله على وجهه، ووَهِم فيه، ولم يتعمّد كذباً. فهو في يده يقول به ويعمل به ويرويه، فيقول: أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلو علم المسلمون أنّه وَهِم لم يقبلوه، ولو علم هو أنّه وَهِم لرفضه.
ورجل ثالث سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً أمر به، ثمّ نهى عنه وهو لا يعلم، أو سمعه ينهى عن شيء، ثمّ أمر به وهو لا يعلم، فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ، ولو علم أنّه منسوخ لرفضه، ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنّه منسوخ لرفضوه.
وآخر رابع لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مبغض للكذب؛ خوفاً من الله، وتعظيماً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم ينسه [لم يسه]، بل حفظ ما سمع على وجهه، فجاء به كما سمع، لم يزد فيه، ولم ينقص منه، وعلم الناسخ من المنسوخ، فعمل بالناسخ، ورفض المنسوخ.
فإنّ أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل القرآن ناسخ ومنسوخ، [وخاصّ وعام]، ومحكم ومتشابه، قد كان يكون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكلام له وجهان: كلام عامّ، وكلام خاصّ، مثل القرآن، وقال الله (عزّ وجلّ) في كتابه:( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) ، فيشتبه على مَنْ لم يعرف ولم يدرِ ما عنى الله به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
وليس كلّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأله عن الشيء فيفهم، وكان منهم مَنْ يسأله ولا يستفهمه حتى إن كانوا ليحبّون أن يجيء الأعرابي والطاري فيسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ حتى يسمعوا...»(١) .
____________________
١ - الكافي ١/٦٢ - ٦٤ باب الاختلاف في الحديث ح ١، واللفظ له، الخصال/٢٥٥ - ٢٥٧ باب الأربعة ح ١٣١، غيبة النعماني/٨٠ - ٨٢ باب٤ ح١٠. =
شكوى أمير المؤمنين (عليه السّلام) من التحريف وتعريضه بالمحرّفين
وقال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) أيضاً: «أين الذين زعموا أنّهم الراسخون في العلم دوننا كذباً وبغياً علينا؟! أن رفعنا الله ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم. بنا يُستعطى الهدى ويُستجلى العمى...»(١) .
قال ابن أبي الحديد: هذا الكلام كناية وإشارة إلى قوم من الصحابة كانوا ينازعونه الفضل، فمنهم مَنْ كان يُدعى له أنّه أفرض، ومنهم مَنْ كان يُدعى له أنّه أقرّ، ومنهم مَنْ كان يُدعى له أنّه أعلم بالحلال والحرام. هذا مع تسليم هؤلاء له (عليه السّلام) أنّه أقضى الأُمّة، وأنّ القضاء يحتاج إلى كلّ هذه الفضائل، وكلّ واحدة منها لا تحتاج إلى غيره.
فهو إذن أجمع للفقه وأكثرهم احتواءً عليه إلّا أنّه (عليه السّلام) لم يرضَ بذلك، ولم يصدق الخبر الذي قيل: أفرضكم فلان... إلى آخره؛ فقال: إنّه كذب وافتراء حمل قوماً على وضعه الحسد والبغي والمنافسة لهذا الحي من بني هاشم، أن رفعهم الله على غيرهم، واختصّهم دون سواهم(٢) .
وعن عباد بن عبد الله الأسدي قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: «أنا عبد الله وأخو رسوله، وأنا الصدّيق الأكبر، لا يقولها غيري إلّا كذّاب، ولقد
____________________
= وروى كلام أمير المؤمنين (عليه السّلام) السيّد الرضي، فقال: ومن كلام له (عليه السّلام) وقد سأله سائل عن أحاديث البدع، وعمّا في أيدي الناس من اختلاف الخبر، فقال (عليه السّلام).... نهج البلاغة ٢/١٨٨، كما روي في كتاب الإمتاع والمؤانسة - للتوحيدي ٣/١٩٧.
وذكر المهمّ من هذا الكلام سبط ابن الجوزي، فقال: قال الشعبي: حدّثني مَنْ سمع علياً (عليه السّلام) وقد سُئل عن سبب اختلاف الناس في الحديث، فقال: «الناس أربعة: منافق...».
وفي رواية كميل بن زياد عنه أنّه قال: «إنّ في أيدي الناس حقاً وباطلاً...، وإنّما يأتيك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس». وذكرهم. تذكرة الخواص/١٤٢ - ١٤٣.
١ - نهج البلاغة ٢/٢٧.
٢ - شرح نهج البلاغة ٩/٨٦.
صلّيت قبل الناس سبع سنين»(١) .
وروت معاذة العدوية قالت: سمعت علياً على منبر البصرة يخطب، يقول: «أنا الصدّيق الأكبر، آمنت قبل أن يُؤمن أبو بكر، وأسلمت قبل أن يُسلم»(٢) . وعنه (عليه السّلام) أنّه قال: «أنا الصدّيق الأكبر، وأنا الفاروق الأوّل، أسلمت قبل إسلام الناس، وصلّيت قبل صلاتهم»(٣) .
وقال ابن عبد البر: وروينا من وجوه عن علي (رضي الله عنه) أنّه كان يقول: «أنا عبد الله وأخو رسول الله، لا يقولها أحد غيري إلّا كذّاب...»(٤) إلى غير ذلك ممّا يظهر منه تكذيب ما اشتهر من أنّ أبا بكر هو الصدّيق، وأنّ عمر هو الفاروق،
____________________
١ - شرح نهج البلاغة ١٣/٢٢٨، تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين/٨٣، وفي ضعفاء العقيلي ٣/١٣٧ في ترجمة عباد بن عبد الله الأسدي أنّه (عليه السّلام) قال: «أنا عبد الله وأخو رسول الله، أنا الصديق الأكبر، وما قالها أحد قبلي وما يقولها إلّا كاذب مفترٍ، ولقد أسلمت وصلّيت قبل الناس سبع سنين». وقد ذكر بدل (لا يقولها غيري) (لا يقولها بعدي) في سنن ابن ماجة ١/٤٤ باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فضل علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، والسنن الكبرى - للنسائي ٥/١٠٧ كتاب الخصائص، ذكر خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، ذكر منزلة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، والمستدرك على الصحيحين ٣/١١٢ كتاب معرفة الصحابة، فضائل علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، ذكر إسلام أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه)، والمصنّف - لابن أبي شيبة ٧/٤٩٨ كتاب الفضائل، فضائل علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، والسُنّة - لابن أبي عاصم/٥٨٤، وغيرها من المصادر الكثيرة.
٢ - تاريخ دمشق ٤٢/٣٣ في ترجمة علي بن أبي طالب، واللفظ له، الآحاد والمثاني ١/١٥١، تهذيب الكمال ١٢/١٨ في ترجمة سليمان بن عبد الله، ضعفاء العقيلي ٢/١٣١ في ترجمة سليمان بن عبد الله، الكامل في ضعفاء الرجال - لابن عدي ٣/٢٧٤ في ترجمة سليمان بن عبد الله، شرح نهج البلاغة ٤/١٢٢، و١٣/٢٢٨، ينابيع المودّة ٢/١٤٦، وغيرها من المصادر.
٣ - شرح نهج البلاغة ١/٣٠، ينابيع المودّة ١/٤٥٥.
وقال ابن أبي الحديد في موضع آخر بعد نقل هذا الحديث عنه (عليه السّلام)، وفي غير رواية الطبري: «أنا الصديق الأكبر، وأنا الفاروق الأوّل، أسلمت قبل إسلام أبي بكر، وصلّيت قبل صلاته بسبع سنين». شرح نهج البلاغة ١٣/٢٠٠.
٤ - الاستيعاب ٣/١٠٩٨ في ترجمة علي بن أبي طالب.
وما روي من أنّ أبا بكر أخو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم(١) .
ونظير ذلك ما عن أبي غطفان أنّه قال: سألت ابن عباس أرأيت أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفّي ورأسه في حجر أحد؟ قال: توفّي وهو لمستند إلى صدر علي. قلت: فإنّ عروة حدّثني عن عائشة أنّها قالت: توفّي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين سحري ونحري. فقال ابن عباس: أتعقل؟! والله لتوفّي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنّه لمستند إلى صدر علي، وهو الذي غسّله وأخي الفضل بن عباس...(٢) .
تأكيد السلطة على أهميّة الإمامة وعلى الطاعة ولزوم الجماعة
الأمر الثالث ممّا قام به الولاة في سبيل دعم سلطانهم: التأكيد على الأمور الثلاثة التي سبق أنّ الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم قد أكّدا عليها في حقّ الإمام المعصوم المجعول من قبل الله تعالى، وهي: وجوب معرفة الإمام والبيعة له، ووجوب طاعته والنصيحة له، ووجوب لزوم جماعته والنهي عن الاختلاف والتفرّق والفتنة.
وقد أغفلت السلطة أنّ ذلك إنّما جعل في حقّ الإمام المنصوص عليه المعصوم، المأمون على الدين والدنيا دون غيره ممّن لا تُؤمن أخطاؤه وبوائقه على الإسلام والمسلمين.
١- فمن الملفت للنظر أنّ كثيراً من طرق رواية ما تضمّن أنّ مَنْ مات بغير
____________________
١ - صحيح البخاري ٤/١٩١ كتاب بدء الخلق: باب مناقب المهاجرين وفضلهم، مسند أحمد ١/٤٦٣ مسند عبد الله بن مسعود، مسند أبي داود الطيالسي/٤٢، المصنّف - لابن أبي شيبة ٧/٤٧٦ كتاب الفضائل، ما ذكر في أبي بكر الصديق (رضي الله عنه)، المعجم الكبير ١٠/١٠٥ ما روي عن عبد الله بن مسعود، وغيرها من المصادر الكثيرة.
٢ - الطبقات الكبرى ٢/٢٦٣ ذكر مَنْ قال توفّي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجر علي بن أبي طالب، واللفظ له، فتح الباري ٨/١٠٧، كنز العمّال ٧/٢٥٣ - ٢٥٤ ح ١٨٧٩١.
إمام مات ميتة جاهلية ونحوه - ممّا تقدّم التعرّض له - تنتهي إلى معاوية بن أبي سفيان(١) الذي بقي هو بلا بيعة، ومن دون أن يدّعي لنفسه الخلافة ما يقرب من ثلاث سنين.
٢- ومن الطريف جدّاً ما رواه ابن الأثير؛ فإنّه - بعد أن ذكر بيعة معاوية ليزيد بالشام بالترغيب والترهيب، وأنّه ورد المدينة فنال من النفر الذين بلغه إباءهم البيعة، وشتمهم في وجوههم، ثمّ خطب فأرعد وأبرق مهدّداً معرّضاً بهم - قال: ثمّ دخل على عائشة وقد بلغها أنّه ذكر الحسين وأصحابه، فقال: لأقتلنّهم إن لم يبايعوا، فشكاهم إليها، فوعظته وقالت له: بلغني أنّك تتهدّدهم بالقتل. فقال: يا أُمّ المؤمنين، هم أعزّ من ذلك، ولكنّي بايعت ليزيد وبايعه غيرهم، أفترين أن أنقض بيعة قد تمّت؟!...(٢) .
فكأنَّ مثل هذه البيعة بيعة إلهية نقضها أعظم جريمة من الموبقات التي ارتكبها معاوية!
٣- ولما تخلّف أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) ومَنْ معه عن بيعة أبي بكر، واجتمعوا في بيت سيّدة النساء الصديقة فاطمة الزهراء (صلوات الله عليه) أرسل إليهم عمر ليخرجهم من بيتها، وقال له: إن أبوا فقاتلهم، فأقبل عمر
____________________
١ - راجع مسند أحمد ٤/٩٦ حديث معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنه)، ومجمع الزوائد ٥/٢١٨ كتاب الخلافة، باب لزوم الجماعة وطاعة الأئمّة والنهي عن قتالهم، وص ٢٢٥ باب لا طاعة في معصية، وكتاب السنة - لابن أبي عاصم/٤٨٩، ومسند أبي يعلى ١٣/٣٦٦، وصحيح ابن حبان ١٠/٤٣٤ كتاب السير، باب طاعة الأئمّة، ذكر الزجر عن ترك اعتقاد المرء الإمام الذي يطيع الله (جلّ وعلا) في أسبابه، والمعجم الأوسط ٦/٧٠، والمعجم الكبير ١٩/٣٣٥ فيما رواه ذكوان أبو صالح السمان عن معاوية، وص ٣٨٨ فيما رواه شريح بن عبيد عن معاوية، وغيرها من المصادر الكثيرة.
٢ - الكامل في التاريخ ٣/٥٠٨ - ٥٠٩ أحداث سنة ست وخمسين من الهجرة، ذكر البيعة ليزيد بولاية العهد، ونحوه في الفتوح - لابن أعثم ٤/٣٤١ ذكر خبر معاوية في خروجه إلى الحج وممّا كان منه بمكة والمدينة ورجوعه.
ومَنْ معه بقبس من نار فلقيتهم سيّدة النساء، وقالت: «يابن الخطاب! أجئت لتُحرق دارنا؟!». قال: نعم، أو تدخلوا فيما دخلت فيه الأُمّة(١) .
٤- ويتحدّث عمر بن الخطاب عن أحداث السقيفة وعن موقفه من سعد بن عبادة؛ لأنّه حاول أن يسبقهم في الاستيلاء على السلطة، فيقول: فقلت وأنا مغضب: قتل الله سعداً؛ فإنّه صاحب فتنة وشرّ(٢) .
٥- وفي حديث لأبي بكر مع العباس بن عبد المطلب حينما ذهب إليه ليجعل له ولعقبه نصيباً في الخلافة؛ ليقطعه بذلك عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) ويضعف موقفه، قال أبو بكر: إنّ الله بعث محمداً نبيّاً... حتى اختار له ما عنده، فخلى على الناس أموراً ليختاروا لأنفسهم في مصلحتهم مشفقين، فاختاروني عليهم والياً، ولأمورهم راعياً...، وما انفك يبلغني عن طاعنٍ يقول الخلاف على عامة المسلمين يتّخذكم لجأ...، فإمّا دخلتم مع الناس فيما اجتمعوا عليه، وإمّا صرفتموهم عمّا مالوا إليها... فقال عمر بن الخطاب: إي والله. وأُخرى: إنّا لم نأتكم لحاجة إليكم، ولكن كرهاً أن يكون الطعن فيما اجتمع عليه المسلمون منكم، فيتفاقم الخطب بكم...فأجاب العباس أبا بكر بكلام طويل، ومنه قوله: فإن كنت برسول الله طلبت فحقنا أخذت، وإن كنت بالمؤمنين فنحن منهم...، وإن كان هذا الأمر إنّما وجب لك بالمؤمنين فما وجب إذ كنّا كارهين. ما أبعد قولك من أنّهم طعنوا عليك من قولك إنّهم اختاروك
____________________
١ - العقد الفريد ٤/٢٤٢ فرش كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم، سقيفة بني ساعدة، واللفظ له، المختصر في أخبار البشر ١/١٥٦ ذكر أخبار أبي بكر الصديق وخلافته.
٢ - صحيح ابن حبان ٢/١٥٧ باب حق الوالدين، الزجر عن أن يرغب المرء عن آبائه إذ استعمال ذلك ضرب من الكفر، تاريخ دمشق ٣٠/٢٨٣ في ترجمة أبي بكر الصديق، تاريخ الإسلام ٣/١١ أحداث سنة إحدى عشر من الهجرة، خلافة أبي بكر (رضي الله عنه)، النهاية في غريب الحديث ٤/١٣، لسان العرب ١١/٥٤٩، وغيرها من المصادر.
ومالوا إليك!...(١) .
٦- وقال الفضل بن شاذان في التعقيب على محاولة القوم قتل أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): فقيل لسفيان وابن حي ولوكيع: ما تقولون فيما كان من أبي بكر في ذلك؟ فقالوا جميعا ً: كانت سيئة لم تتم، وأمّا مَنْ يجسر من أهل المدينة فيقولون: وما بأس بقتل رجل في صلاح الأُمّة؛ إنّه إنّما أراد قتله لأنّ علياً أراد تفريق الأُمّة، وصدّهم عن بيعة أبي بكر(٢) .
٧- ولما امتنعت كندة من بيعة أبي بكر وطاعته وتسليم زكاتها له؛ لأنّها ترى أنّ الحقّ في بني هاشم، وقتل منها مَنْ قتل، وجرت خطوب طويلة في ذلك، كتب أبو بكر إلى الأشعث بن قيس يتهدّده، فلمّا وصل الكتاب إلى الأشعث وقرأه قال للرسول: إنّ صاحبك أبا بكر هذا يلزمنا الكفر بمخالفتنا له، ولا يلزم صاحبه الكفر بقتله قومي وبني عمّي؟! فقال له الرسول: نعم يا أشعث، يلزمك الكفر؛ لأنّ الله تبارك وتعالى قد أوجب عليك الكفر بمخالفتك لجماعة المسلمين(٣) .
٨- وفي خطبة لأبي بكر: «وإنكم اليوم على خلافة نبوة ومفرق محجة. وسترون بعدي ملكاً عضوضاً، وأمة شَعاعاً، ودماً مفاحاً. فإن كانت للباطل نزوة، ولأهل الحق جولة، يعفو لها الأثر، وتموت السنن. فالزموا المساجد، واستشيروا القرآن، والزموا الجماعة...»(٤) .
____________________
١ - تاريخ اليعقوبي ٢/١٢٥ خبر سقيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكر، واللفظ له، الإمامة والسياسة ١/١٨ كيف كانت بيعة علي بن أبي طالب (كرّم الله وجهه)، شرح نهج البلاغة ١/٢٢٠.
٢ - الإيضاح/١٥٧ - ١٥٨.
٣ - الفتوح - لابن أعثم ١/٥٦ ذكر كتاب أبي بكر إلى الأشعث بن قيس ومَنْ معه من قبائل كندة.
٤- عيون الأخبار ج:٢ ص: ٢٣٣ كتاب العلم والبيان. الخطب، واللفظ له. نثر الدر ج:٢ ص:٧ الباب الأول من الفصل الثاني: في كلام أبي بكر الصديق رحمة الله عليه ورضي الله عنه. ومثل ذلك في العقد الفريد ج: ٤ ص: ٦٢ فرش كتاب الخطب، إلا أنه فيه: «واعتصموا بالطاعة» بدل «والزموا الجماعة».
٩- كما أن علقمة بن علاثة قد رأى عمر بن الخطاب مساء في الظلام فظنّه خالد بن الوليد، فشدّد في الاستنكار على عمر وذمّه لعزله لخالد ونزعه من الولاية، فأبقاه عمر على غفلته، وقال له: نزعني فما عندك في نزعي؟ فقال علقمة: وماذا عندي في نزعك؟! هؤلاء قوم ولّوا أمراً، ولهم علينا حقّ، فنحن مؤدّون إليهم الحقّ الذي جعله الله لهم، وأمرنا - أو قال: وحسابنا - على الله. وفي الصباح لما اجتمع خالد وعلقمة عند عمر أظهر عمر حقيقة الحال، وأنّ حديث علقمة لم يكن مع خالد، بل مع عمر نفسه، وعزّر عمر علقمة لذمّه إيّاه، ثمّ قال عن كلمته السابقة في الطاعة وعدم محاولة التغيير من أجل عزل خالد: إنّه قال كلمة لأن يقولها مَنْ أصبح من أُمّة محمد أحبّ إليّ من حمر النعم(١) .
١٠- وعن عبد الملك بن عمير قال: كان عامّة خطبة يزيد بن أبي سفيان وهو على الشام: عليكم بالطاعة والجماعة، فمن ثمّ لا يعرف أهل الشام إلّا الطاعة(٢) .
١١- وفي صحيح أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر [يعني: الإمام الباقر] (عليه السّلام) يقول: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - ومعاوية يكتب بين يديه وأهوى بيده إلى خاصرته بالسيف - مَنْ أدرك هذا يوماً أميراً فليبقر خاصرته بالسيف، فرآه رجل ممّن سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوماً وهو يخطب بالشام على الناس، فاخترط سيفه ثمّ مشى إليه، فحال الناس بينه وبينه، فقالوا: يا عبد الله، ما لك؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مَنْ أدرك هذا يوماً أميراً فليبقر خاصرته بالسيف. فقالوا: أتدري مَنْ استعمله؟ قال: لا. قالوا: أمير المؤمنين عمر. فقال: سمعاً
____________________
١ - تاريخ المدينة ٣/٧٩٥، واللفظ له، الإصابة ٤/٤٥٩ في ترجمة علقمة بن علاثة، تاريخ دمشق ٤١/١٤١ في ترجمة علقمة بن علاثة، وغيرها من المصادر.
٢ - تاريخ دمشق ١/٣١٩ باب ما ذكر من تمسك أهل الشام بالطاعة واعتصامهم بلزوم السنة والجماعة.
وطاعة لأمير المؤمنين»(١) .
١٢- وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنّا مع عبد الله بن مسعود بجمع، فلمّا دخل مسجد منى فقال: كم صلّى أمير المؤمنين؟ قالوا: أربعاً. فصلّى أربعاً. قال: فقلنا له: ألم تحدّثنا أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلّى ركعتين، وأبا بكر صلّى ركعتين؟ فقال: بلى، وأنا أحدّثكموه الآن، ولكنّ عثمان كان إماماً فما أخالفه، والخلاف شرّ(٢) . وروى غير واحد نحو ذلك عن ابن مسعود(٣) .
١٣- وذكر ابن الأثير أنّ عبد الرحمن بن عوف أنكر على عثمان إتمامه الصلاة، وقال: فخرج عبد الرحمن فلقي ابن مسعود، فقال: يا أبا محمد، غيّر ما تعلم. قال: فما أصنع؟ قال: اعمل بما ترى وتعلم. فقال ابن مسعود: الخلاف شرّ، وقد صلّيت بأصحابي أربعاً. فقال عبد الرحمن: قد صلّيت بأصحابي ركعتين، وأمّا الآن فسوف أصلّي أربعاً(٤) .
١٤- وقال الحارث بن قيس: قال لي عبد الله بن مسعود: أتحبّ أن يسكنك الله وسط الجنّة؟
قال: فقلت: جُعلت فداك! وهل أُريد إلّا ذلك؟! قال: عليك بالجماعة، أو لجماعة الناس(٥) .
____________________
١ - معاني الأخبار/٣٤٦ باب معنى استعانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعاوية في كتابة الوحي.
٢ - السنن الكبرى - للبيهقي ٣/١٤٤ باب مَنْ ترك القصر في السفر غير رغبة عن السُنّة، واللفظ له، تاريخ دمشق ٣٩/٢٥٤ في ترجمة عثمان بن عفان.
٣ - السنن الكبرى - للبيهقي ٣/١٤٤ باب مَنْ ترك القصر في السفر غير رغبة عن السُنّة، سنن أبي داود ١/٤٣٨ كتاب المناسك، باب الصلاة بمنى، المعجم الأوسط ٦/٣٦٨، المصنّف - لعبد الرزاق الصنعاني ٢/٥١٦ كتاب الصلاة: باب الصلاة في السفر، مسند أبي يعلى ٩/٢٥٦، البداية والنهاية ٧/٢٤٤، فتح الباري ٢/٤٦٥، عمدة القاري ٧/١٢٠ - ١٢٢، معرفة السنن والآثار ٢/٤٢٦ - ٤٢٧، التمهيد - لابن عبد البر ١١/١٧٢، تأويل مختلف الحديث/٢٧، تاريخ دمشق ٣٩/٢٥٥ في ترجمة عثمان بن عفان، وغيرها من المصادر.
٤ - الكامل في التاريخ ٣/١٠٤ أحداث سنة تسع وعشرين من الهجرة، ذكر إتمام عثمان الصلاة بجمع.
٥ - المصنّف - لابن أبي شيبة ٨/٦٤٥ كتاب المغازي، من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنه، مجمع =
١٥- وفي خطبة لابن مسعود: أيّها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة؛ فإنّه حبل الله الذي أمر به، وإنّ ما تكرهون في الجماعة خير ممّا تحبّون في الفرقة(١) .
١٦- وعن أبي مسعود أنّه قال: عليكم بالجماعة؛ فإنّ الله لم يكن ليجمع أُمّة محمد على ضلالة(٢) . وفي حديث له آخر: عليك بعظم أُمّة محمد...(٣) .
١٧- وفي أحداث الشورى حينما بايع عبد الرحمن بن عوف عثمان تلكأ أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)؛ مؤكّداً على أنّه الأولى بالأمر وبأن يُبايَع، وأخذ يذكر جملة من فضائله التي يتميّز بها على غيره، فقطع عليه عبد الرحمن كلامه وقال: يا علي، قد أبى الناس إلّا عثمان، فلا تجعلنّ على نفسك سبيلاً. ثمّ قال: يا أبا طلحة، ما الذي أمرك به عمر؟ قال: أن أقتل مَنْ شقّ عصا الجماعة. فقال عبد الرحمن لأمير المؤمنين (عليه السّلام): بايع إذن، وإلاّ كنت متّبعاً غير سبيل المؤمنين، وأنفذنا فيك ما أمرنا به!(٤) .
١٨- وفي حديث شقيق بن سلمة أنّ أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) لما انصرف إلى رحله قال لبني أبيه: «يا بني عبد المطلب، إنّ قومكم عادوكم بعد
____________________
= الزوائد ٥/٢٢٢ كتاب الخلافة، باب لزوم الجماعة والنهي عن الخروج على الأئمّة وقتالهم، كنز العمّال ١/٣٨٠ ح ١٦٥٤، المعجم الكبير ٩/١٩٨ في نقل كلام ابن مسعود.
١ - التمهيد - لابن عبد البر ٢١/٢٧٣، واللفظ له، الاستذكار - لابن عبد البر ٨/٥٧٧، مجمع الزوائد ٥/٢٢٢ كتاب الخلافة، باب لزوم الجماعة والنهي عن الخروج على الأئمّة وقتالهم، و٧/٣٢٨ كتاب الفتن، باب ثانٍ في أمارات الساعة، المعجم الكبير ٩/١٩٩ في نقل كلام ابن مسعود، وقد روي بعضه في تفسير الطبري ٤/٤٥، وتفسير ابن أبي حاتم ٣/٧٢٣، وتفسير الثعلبي ٣/١٦٢، والدرّ المنثور ٢/٦٠، وغيرها من المصادر.
٢ - المصنف - لابن أبي شيبة ٨/٦٧٢ كتاب المغازي، ما ذكر في فتنة الدجّال، واللفظ له، كتاب السُنّة - لابن أبي عاصم/٤١ - ٤٢، سير أعلام النبلاء ٢/٤٩٥ - ٤٩٦ في ترجمة أبي مسعود البدري، كنز العمّال ١/٣٨٤ ح ١٦٦٣، كشف الخفاء ٢/٣٥٠.
٣ - المستدرك على الصحيحين ٤/٥٥٦ كتاب الفتن والملاحم، ما تكرهون في الجماعة خير ممّا تحبّون في الفرقة.
٤ - شرح نهج البلاغة ٦/١٦٨.
وفاة النبي كعداوتهم النبي في حياته، وإن يُطَع قومكم لا تؤمّروا أبداً. ووالله، لا ينيب هؤلاء إلى الحقّ إلّا بالسيف». قال: وعبد الله بن عمر بن الخطاب داخل إليهم قد سمع الكلام كلّه، فدخل وقال: يا أبا الحسن، أتريد أن تضرب بعضهم ببعض؟! فقال: «اسكت ويحك! فوالله، لولا أبوك وما ركب منّي قديماً وحديثاً ما نازعني ابن عفّان ولا ابن عوف». فقام عبد الله فخرج(١) .
١٩- كما إنّ المقداد (رضي الله عنه) قد أنكر ذلك أيضاً، وكان فيما قال: أما والله، لو أنّ لي على قريش أعواناً لقاتلتهم قتالي إيّاهم ببدر وأُحد. فقال عبد الرحمن بن عوف: ثكلتك أُمّك! لا يسمعنّ هذا الكلام الناس؛ فإنّي أخاف أن تكون صاحب فتنة وفرقة. فقال له المقداد: إنّ مَنْ دعا إلى الحقّ وأهله لا يكون صاحب فتنة، ولكن مَنْ أقحم الناس في الباطل، وآثر الهوى على الحقّ، فذلك صاحب الفتنة والفرقة. فتربّد وجه عبد الرحمن(٢) .
٢٠- وعن صهبان مولى الأسلميين قال: رأيت أبا ذرّ يوم دُخل به على عثمان، فقال له: أنت الذي فعلت وفعلت؟ فقال أبو ذرّ: نصحتك فاستغششتني، ونصحت صاحبك فاستغشني. قال عثمان: كذبت، ولكنّك تريد الفتنة وتحبّها، قد أنغلت الشام علينا... قال أبوذر: والله ما وجدت لي عذراً إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فغضب عثمان، وقال: أشيروا عليّ في هذا الشيخ الكذّاب، إما أن أضربه أو أقتله، فإنه قد فرّق جماعة المسلمين، أو أنفيه من أرض الإسلام...(٣) .
٢١- وعتب عثمان على أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) لتوديعه أباذر،
____________________
١ - شرح نهج البلاغة ٩/٥٤.
٢ - شرح نهج البلاغة ٩/٥٧، واللفظ له، وذكر بعضه في الأمالي - للمفيد/١٧١، والأمالي - للطوسي/١٩١.
٣ - شرح نهج البلاغة ٣/٥٦، واللفظ له، الشافي في الإمامة ٤/٢٩٦.
وكان عثمان قد نهى الناس عن كلامه وتشييعه، فقال عثمان له (عليه السلام): «أما بلغك نهيي عن كلام أبي ذر؟» فأجابه أمير المؤمنين (عليه السلام) قائلاً: «أو كلما أمرت بأمر معصية أطعناك فيه؟!»(١) .
٢٢- وعن عبد الله بن رباح قال: دخلت أنا وأبو قتادة على عثمان وهو محصور، فاستأذناه في الحجّ فأذن لنا. فقلنا: يا أمير المؤمنين، قد حضر من أمر هؤلاء ما قد ترى، فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالجماعة. قلنا: فإنّا نخاف أن تكون الجماعة مع هؤلاء الذين يخالفونك. قال: ألزموا الجماعة حيث كانت...(٢) .
وسواء صحّ هذا الحديث أم لم يصح؛ فإنّه يكشف عن وجود مثل هذه الثقافة، وتبنّي بعض الناس لها؛ سواءً كان هو عثمان، أم مَنْ يتقوّل عليه.
٢٣- ولما طلب زياد عامل معاوية على الكوفة من وجوه أهل الكوفة أن يشهدوا على حجر بن عدي وجماعته بما يدينهم عند معاوية كتب أبو بردة بن أبي موسى الأشعري: هذا ما شهد عليه الشهود أبو بردة بن أبي موسى لله ربّ العالمين. شهد أنّ حجر بن عدي خلع الطاعة، وفارق الجماعة، ولعن الخليفة، ودعا إلى الحرب والفتنة، وجمع إليه جموعاً يدعوهم إلى نكث البيعة وخلع أمير المؤمنين معاوية؛ فكفر بالله كفرة صلعاء، وأتى معصية شنعاء. فقال زياد: اشهدوا على مثل شهادته. فشهد جماعة كما قال(٣) .
٢٤- ولما كتب مروان بن الحكم إلى معاوية يخوّفه من وثوب الإمام الحسين (صلوات الله عليه) وخروجه عليه، كتب معاوية للإمام (عليه السّلام) كتاباً يحذّره فيه،
____________________
١ - شرح نهج البلاغة ج:٨ ص:٢٥٤.
٢ - المصنّف - لعبد الرزاق ١١/٤٤٦ باب مقتل عثمان.
٣ - أنساب الأشراف ٥/٢٦٢ أمر حجر بن عدي ومقتله، واللفظ له، تاريخ الطبري ٤/٢٠٠ أحداث سنة إحدى وخمسين من الهجرة، ذكر سبب مقتل حجر بن عدي، الأغاني ١٧/١٤٥ - ١٤٦ خبر مقتل حجر بن عدي.
وجاء فيه: فاتّقِ شقّ عصا هذه الأُمّة، وأن يردّهم الله على يديك في فتنة، فقد عرفت الناس وبلوتهم، فانظر لنفسك ولدينك، ولأُمّة محمد صلى الله عليه وآله وسلم....
فأجابه (عليه السّلام) على هذه الفقرة في كتابه له: «وإنّي لا أعلم فتنة أعظم على هذه الأُمّة من ولايتك عليها، ولا أعظم نظراً لنفسي ولديني ولأُمّة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلينا أفضل من أن أجاهدك...»(١) .
٢٣- ولما أراد معاوية البيعة ليزيد بولاية العهد قال للضحاك بن قيس الفهري لما اجتمع الوفود عنده: إنّي متكلّم، فإذا سكت فكن أنت الذي تدعو إلى بيعة يزيد، وتحّثني عليها.
فلمّا جلس معاوية للناس تكلّم، فعظّم أمر الإسلام، وحرمة الخلافة وحقّه، وما أمر الله به من طاعة ولاة الأمر، ثمّ ذكر يزيد وفضله وعلمه بالسياسة، وعرض ببيعته.
فعارضه الضحّاك، فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: يا أمير المؤمنين، إنّه لا بدّ للناس من والٍ بعدك، وقد بلونا الجماعة والألفة، فوجدناهما أحقن للدماء، وأصلح للدهماء، وآمن للسبل، وخيراً في العاقبة، والأيام عوج رواجع، والله كلّ يوم في شأن. ويزيد بن أمير المؤمنين في حسن هديه، وقصد سيرته، على ما علمت، وهو من أفضلنا علماً وحلماً، وأبعدنا رأياً؛ فولّه عهدك، واجعله لنا علماً بعدك، ومفزعاً نلجأ إليه، ونسكن في ظلّه. وتكلّم عمرو بن سعيد الأشدق بنحو من ذلك.
ثمّ قام يزيد بن المقنع العذري، فقال: هذا أمير المؤمنين - وأشار إلى معاوية - فإن هلك فهذا - وأشار إلى يزيد - ومَنْ أبى فهذا. وأشار إلى سيفه.
____________________
١ - اختيار معرفة الرجال ١/١٢٠ - ١٢٤ في ترجمة عمرو بن الحمق الخزاعي.
فقال معاوية: اجلس، فأنت سيّد الخطباء. وتكلّم مَنْ حضر من الوفود.
فقال معاوية للأحنف: ما تقول يا أبا بحر؟ فقال: نخافكم إن صدقنا، ونخاف الله إن كذبنا، وأنت يا أمير المؤمنين أعلم بيزيد في ليله ونهاره، وسرّه وعلانيته، ومدخله ومخرجه، فإن كنت تعلمه لله تعالى وللأُمّة رضى فلا تشاور فيه، وإن كنت تعلم فيه غير ذلك فلا تزوّده الدنيا وأنت صائر إلى الآخرة، وإنّما علينا أن نقول: سمعنا وأطعنا!
وقام رجل من أهل الشام فقال: ما ندري ما تقول هذه المعدية العراقية، وإنّما عندنا سمع وطاعة، وضرب وازدلاف!(١) .
٢٦- وقال معاوية أيضاً لعبد الله بن عمر حين أراد البيعة ليزيد: قد كنت تحدّثنا أنّك لا تحبّ أن تبيت ليلة وليس في عنقك بيعة جماعة وأنّ لك الدنيا وما فيها، وإنّي أُحذّرك أن تشقّ عصا المسلمين وتسعى في تفريق ملئهم، وأن تسفك دماءهم....
فأجابه ابن عمر، وقال في جملة ما قال:... وإنّك تحذّرني أن أشقّ عصا المسلمين، وأفرّق ملأهم، وأسفك دماءهم، ولم أكن لأفعل ذلك إن شاء الله، ولكن إن استقام الناس فسأدخل في صالح ما تدخل فيه أُمّة محمد(٢) .
٢٧- وكتب يزيد بن معاوية لابن عباس بعد خروج الإمام الحسين
____________________
١ - الكامل في التاريخ ٣/٥٠٧ - ٥٠٨ أحداث سنة ست وخمسين من الهجرة، ذكر البيعة ليزيد بولاية العهد، واللفظ له، الفتوح - لابن أعثم ٤/٣٣٦ - ٣٣٧ ثمّ رجعنا إلى الخبر الأوّل، نهاية الإرب في فنون الأدب ٢٠/٢٢٢ أحداث سنة ست وخمسين من الهجرة، من وفد إلى معاوية من أهل الأمصار.
٢ - الإمامة والسياسة ١/١٥١ - ١٥٢ قدوم معاوية المدينة على هؤلاء القوم وما كان بينهم من المنازعة، واللفظ له، تاريخ الإسلام ٤/١٤٨ - ١٤٩ الطبقة السادسة، أحداث سنة أحدى وخمسين من الهجرة، تاريخ خليفة بن خياط/١٦٠ - ١٦١ أحداث سنة أحدى وخمسين من الهجرة، وغيرها من المصادر.
(صلوات الله عليه) إلى مكة، وجاء في كتابه: وأنت كبير أهل بيتك والمنظور إليه، فاكففه عن السعي في الفرقة(١) .
٢٨- ولما علم يزيد امتناع ابن عباس من البيعة لابن الزبير كتب إليه: أمّا بعد، فقد بلغني أنّ الملحد ابن الزبير دعاك إلى بيعته، وعرض عليك الدخول في طاعته؛ لتكون على الباطل ظهيراً، وفي المأثم شريكاً، وأنّك امتنعت عليه، واعتصمت ببيعتنا؛ وفاءً منك لنا، وطاعة لله فيما عرّفك من حقّنا...، وانظر رحمك الله فيمَنْ قِبَلك من قومك ومَنْ يطرأ عليك من الآفاق... فأعلمهم حسن رأيك في طاعتي والتمسّك ببيعتي...(٢) .
٢٩- ولقي عبد الله بن عمر وابن عباس منصرفين من العمرة الإمام الحسين (عليه السّلام) وعبد الله بن الزبير بالأبواء، فقال لهما ابن عمر: أذكّركما الله إلّا رجعتم فدخلتما في صالح ما يدخل فيه الناس، وتنظرا، فإن اجتمع الناس عليه لم تشذّا، وإن افترق عليه كان الذي تريدان(٣) . وفي رواية أخرى: اتقيا الله، ولا تفرّقا بين جماعة المسلمين(٤) .
____________________
١ - سير أعلام النبلاء ٣/٣٠٤ في ترجمة الحسين الشهيد، البداية والنهاية ٨/١٧٧ أحداث سنة ستين من الهجرة، صفة مخرج الحسين إلى العراق، تاريخ دمشق ١٤/٢١٠ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، واللفظ له، تهذيب الكمال ٦/٤١٩ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، ترجمة الإمام الحسين (عليه السّلام) من طبقات ابن سعد/٥٩ ح ٢٨٣، وغيرها من المصادر.
٢ - تاريخ اليعقوبي ٢/٢٤٧ مقتل الحسين بن علي، واللفظ له. الكامل في التاريخ ٤/١٢٧ أحداث سنة أربع وستين من الهجرة: ذكر بعض سيرته (يزيد) وأخباره. مجمع الزوائد ٧/٢٥٠ كتاب الفتن: باب فيما كان من أمر ابن الزبير. المعجم الكبير ١٠/٢٤١ مناقب عبد الله بن عباس وأخباره. وغيرها من المصادر.
٣ - تاريخ دمشق ١٤/٢٠٨ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، واللفظ له، تهذيب الكمال ٦/٤١٦ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، ترجمة الإمام الحسين (عليه السّلام) من طبقات ابن سعد/٥٧ ح٢٨٣، وغيرها من المصادر.
٤ - البداية والنهاية ٨/١٥٨ أحداث سنة ستين من الهجرة النبوية، يزيد بن معاوية وما جرى في أيامه، =
٣٠- وكان عبد الله بن عمر يقول: غلبنا حسين بن علي بالخروج، ولعمري لقد رأى في أبيه وأخيه عبرة، ورأى من الفتنة وخذلان الناس لهم ما كان ينبغي له أن لا يتحرّك ما عاش، وأن يدخل في صالح ما دخل فيه الناس؛ فإنّ الجماعة خير(١) .
٣١- وقد سبق في المقدّمة كتاب عمرة بنت عبد الرحمن للإمام الحسين (صلوات الله عليه) تعظم عليه ما يريد، وتأمره بالطاعة ولزوم الجماعة(٢) .
٣٢- ولما خرج (عليه السّلام) من مكّة متّجهاً إلى العراق اعترضته رسل عمرو بن سعيد بن العاص فامتنع عليهم امتناعاً قوياً، ومضى (عليه السّلام) لوجهه؛ فنادوه: يا حسين، ألا تتّقي الله، تخرج من الجماعة، وتفرّق بين هذه الأُمّة؟! فتأوّل (عليه السّلام) قول الله (عزّ وجلّ):( لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَاْ بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ) (٣) .
٣٣- وكتب عمرو بن سعيد للإمام الحسين (صلوات الله عليه) يحاول صرفه عن وجهه، ويحثّه على الرجوع، وجاء في كتابه: فإنّي أُعيذك بالله من الشقاق... فكتب إليه الإمام الحسين (عليه السّلام) جواباً لكتابه، وكان فيه: «وإنّه لم
____________________
= واللفظ له، تاريخ الطبري ٤/٢٥٤ أحداث سنة ستين من الهجرة، خلافة يزيد بن معاوية.
١ - تاريخ دمشق ١٤/٢٠٨ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، واللفظ له، البداية والنهاية ٨/١٧٥ أحداث سنة ستين من الهجرة، صفة مخرج الحسين إلى العراق، تهذيب الكمال ٦/٤١٦ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، ترجمة الإمام الحسين من طبقات ابن سعد/٥٧ ح٢٨٣، وغيرها من المصادر.
٢ - تقدّم في/٤٢.
٣ - سورة يونس/١٠، تجد ذلك في تاريخ الطبري ٤/٢٨٩ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مسير الحسين (عليه السّلام) من مكّة متوجّهاً إلى الكوفة وما كان من أمره في مسيره، واللفظ له، البداية والنهاية ٨/١٧٩ أحداث سنة ستين من الهجرة، صفة مخرج الحسين إلى العراق.
يُشاقق مَنْ دعا إلى الله وعمل صالحاً، وقال إنّني من المسلمين»(١) .
٣٤- ولما علم النعمان بن بشير والي الكوفة بقدوم مسلم بن عقيل واختلاف الناس إليه خطب الناس، وكان في جملة ما قال: أمّا بعد، فاتّقوا الله عباد الله، ولا تسارعوا إلى الفتنة والفرقة؛ فإنّ فيهما يهلك الرجال، وتُسفك الدماء، وتُغصب الأموال. وقال: إنّي لم أُقاتل مَنْ لم يقاتلني...، ولكنّكم إن أبديتم صفحتكم لي، ونكثكم بيعتكم، وخالفتم إمامكم، فوالله الذي لا إله إلّا هو لأضربنّكم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي، ولو لم يكن لي منكم ناصر، أما إنّي أرجو أن يكون مَنْ يعرف الحق منكم أكثر ممّن يرديه الباطل(٢) . ومع ذلك يقول عنه مَنْ يقول: وكان حليماً ناسكاً يحبّ العافية(٣) .
٣٥- وأُخذ مسلم بن عقيل (عليه السّلام) أسيراً لابن زياد، فلمّا انتهوا به إلى باب القصر فإذا قلّة باردة موضوعة على الباب، فقال: اسقوني من هذا الماء، فقال
____________________
١ - تاريخ دمشق ١٤/٢٠٩ - ٢١٠ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، واللفظ له، تهذيب الكمال ٦/٤١٩ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، تاريخ الطبري ٤/٢٩٢ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مسير الحسين (عليه السّلام) من مكّة متوجّهاً إلى الكوفة وما كان من أمره في مسيره، البداية والنهاية ٨/١٧٦ - ١٧٧ أحداث سنة ستين من الهجرة، صفة مخرج الحسين إلى العراق، ترجمة الإمام الحسين (عليه السّلام) من طبقات ابن سعد/٥٧ ح٢٨٣، وغيرها من المصادر.
٢ - تاريخ الطبري ٤/٢٦٤ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين (عليه السّلام) للمسير إلى ما قبلهم وأمر مسلم بن عقيل (رضي الله عنه)، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/٢٢ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين (عليه السّلام) ليسير إليهم وقتل مسلم بن عقيل (رضي الله عنه)، الفتوح - لابن أعثم ٥/٣٩ ذكر نزول مسلم بن عقيل الكوفة واجتماع الشيعة إليه للبيعة، وذكر باختصار في تاريخ ابن خلدون ٣/٢٢ مسير الحسين إلى الكوفة ومقتله.
٣ - تاريخ الطبري ٤/٢٦٤ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين (عليه السّلام) للمسير إلى ما قبلهم وأمر مسلم بن عقيل (رضي الله عنه)، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/٢٢ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين (عليه السّلام) ليسير إليهم وقتل مسلم بن عقيل (رضي الله عنه)، وقريب منه ما في تاريخ ابن خلدون ٣/٢٢ مسير الحسين إلى الكوفة ومقتله.
له مسلم بن عمرو: أتراها ما أبردها؟ لا والله، لا تذوق منها قطرة أبداً حتى تذوق الحميم في نار جهنم. فقال له مسلم: ويحك مَنْ أنت؟! قال: أنا ابن مَنْ عرف الحق إذ أنكرته، ونصح لإمامه إذ غششته، وسمع وأطاع إذ عصيته وخالفته. أنا مسلم بن عمرو الباهلي. فقال مسلم (عليه السّلام): لأُمّك الثكل، ما أجفاك، وما أفظّك وأقسى قلبك وأغلظك! أنت يابن باهلة أولى بالحميم والخلود في نار جهنم منّي(١) .
٣٦- ولما أُدخل على ابن زياد قال له ابن زياد: يا شاق ويا عاق، خرجت على إمامك، وشققت عصا المسلمين، وألقحت الفتنة فقال له مسلم: كذبت يابن زياد، إنّما شقّ عصا المسلمين معاوية وابنه يزيد، وأمّا الفتنة فإنّما ألقحها أنت وأبوك زياد بن عبيد عبد بني علاج(٢) .
٣٧- ولما عسكر عبيد الله بن زياد بالنخيلة؛ ليخرج الناس لحرب الإمام الحسين (صلوات الله عليه) دعا كثير بن شهاب الحارثي، ومحمد بن الأشعث بن قيس، والقعقاع بن سويد بن عبد الرحمن، وأسماء بن خارجة الفزاري، وقال: طوفوا في الناس فمروهم بالطاعة والاستقامة، وخوّفوهم عواقب الأمور والفتنة والمعصية، وحثّوهم على العسكرة، فخرجوا فعذروا، وداروا بالكوفة، ثمّ لحقوا به غير كثير بن شهاب؛ فإنّه كان مبالغاً يدور بالكوفة يأمر الناس بالجماعة،
____________________
١ - تاريخ الطبري ٤/٢٨١ - ٢٨٢ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين (عليه السّلام) للمسير إلى ما قبلهم وأمر مسلم بن عقيل (رضي الله عنه)، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/٣٤ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين بن علي ليسير إليهم وقتل مسلم بن عقيل، البداية والنهاية ٨/١٧١ - ١٧٢ أحداث سنة ستين من الهجرة، قصة الحسين بن علي وسبب خروجه من مكة في طلب الإمارة ومقتله، مقاتل الطالبيين/٦٦ مقتل الحسين (عليه السّلام)، وغيرها من المصادر.
٢ - اللهوف في قتلى الطفوف/٣٥، ومثله في الفتوح - لابن أعثم ٥/٦٤ ذكر دخول مسلم بن عقيل على عبيد الله بن زياد وما كان من كلامه وكيف قتل.
ويحذّرهم الفتنة والفرقة، ويُخذّل عن الإمام الحسين (صلوات الله عليه)(١) .
٣٨- ولما جاء مالك بن النسير برسالة عبيد الله بن زياد للحرّ بن يزيد الرياحي يأمره فيها بأن يجعجع بالإمام الحسين (عليه السّلام)، وينزله بالعراء على غير ماء، قال أبو الشعثاء الكندي من أصحاب الإمام (عليه السّلام) لمالك: ثكلتك أُمّك، ماذا جئت فيه؟! فقال مالك: وما جئت فيه؟! أطعت إمامي، ووفيت ببيعتي. فقال له أبو الشعثاء: عصيت ربّك، وأطعت إمامك في هلاك نفسك، وكسبت العار والنار؛ قال الله (عزّ وجلّ):( وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ) (٢) فهو إمامك(٣) .
٣٩- وقال عمرو بن الحجّاج في المعركة يوم عاشوراء: يا أهل الكوفة، ألزموا طاعتكم وجماعتكم، ولا ترتابوا في قتل مَنْ مرق من الدين، وخالف الإمام. فقال له الإمام الحسين (عليه السّلام): «يا عمرو بن الحجّاج، أعليّ تحرّض الناس؟! أنحن مرقنا من الدين وأنتم ثبتم عليه؟! أما والله، لتعلمنّ لو قد قُبضت أرواحكم، ومتّم على أعمالكم، أيّنا مرق من الدين، ومَنْ هو أولى بصلي النار»(٤) .
٤٠- وعن أبي إسحاق قال: كان شمر بن ذي الجوشن يصلّي معنا الفجر، ثمّ يقعد حتى يصبح، ثمّ يصلّي فيقول: اللّهمّ إنّك شريف تحبّ الشرف، وأنت
____________________
١ - أنساب الأشراف ٣/٣٨٧ خروج الحسين بن علي من مكة إلى الكوفة.
٢ - سورة القصص/٤١.
٣ - تاريخ الطبري ٤/٣٠٩ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، واللفظ له، الفتوح - لابن أعثم ٥/٨٧ ذكر الحر بن يزيد الرياحي لما بعثه عبيد الله بن زياد لحربه الحسين بن علي (رضي الله عنهم)، الإرشاد ٢/٨٣ - ٨٤.
٤ - تاريخ الطبري ٤/٣٣١ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/٦٧ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، البداية والنهاية ٨/١٩٧ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتله مأخوذة من كلام أئمّة الشأن.
تعلم أنّي شريف، فاغفر لي. فقلت: كيف يغفر الله لك وقد خرجت إلى ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعنت على قتله؟! قال: ويحك! فكيف نصنع؟! إن أمراءنا هؤلاء أمرونا بأمر، ولو خالفناهم كنّا شرّاً من هذه الحمر(١) .
٤١- ولما خلع أهل المدينة يزيد أنكر عبد الله بن عمر ذلك(٢) ، ودعا بنيه وجمعهم، وقال: إنّا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إنّ الغادر يُنصب له لواء يوم القيامة، فيقول: هذه غدرة فلان...». فلا يخلعنّ أحد منكم يزيد... فتكون الصيلم بيني وبينه(٣) .
٤٢- وكان أهل المدينة حينما خلعوا بيعة يزيد قد حبسوا بني أُميّة وضيّقوا عليهم، فلمّا أقبل جيش أهل الشام بقيادة مسلم بن عقبة أفرجوا عنهم، وسمحوا لهم بالخروج من المدينة بعد أن أخذوا منهم عهد الله تعالى وميثاقه على أن لا يبغوهم غائلة، ولا يدلوا على عورة لهم، ولا يُظاهروا عليهم عدوّاً.
لكنّ عبد الملك بن مروان حينما دخل على مسلم بن عقبة في الطريق، واستشاره مسلم في خطّة القتال أشار عليه بخطّة محكمة - سار عليها مسلم -
____________________
١ - تاريخ الإسلام ٥/١٢٥ في ترجمة شمر بن ذي الجوشن، واللفظ له، تاريخ دمشق ٢٣/١٨٩ في ترجمة شمر بن ذي الجوشن، ميزان الاعتدال ٢/٢٨٠ في ترجمة شمر بن ذي الجوشن، وغيرها من المصادر.
٢ - صحيح البخاري ٨/٩٩ كتاب الفتن، باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال بخلافه، السنن الكبرى - للبيهقي ٨/١٥٩ كتاب قتال أهل البغي، باب إثم الغادر للبر والفاجر، مسند أحمد ٢/٤٨، ٩٦ مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنهم)، تفسير ابن كثير ٢/٦٠٥، الطبقات الكبرى ٤/١٨٣ في ذكر عبد الله بن عمر بن الخطاب، وغيرها من المصادر الكثيرة.
٣ - الطبقات الكبرى ٤/١٨٣ في ذكر عبد الله بن عمر بن الخطاب، واللفظ له، صحيح البخاري ٨/٩٩ كتاب الفتن، باب إذا قال عند قوم شيئاً ثمّ خرج فقال بخلافه، السنن الكبرى - للبيهقي ٨/١٥٩ كتاب قتال أهل البغي، باب إثم الغادر للبرّ والفاجر، مسند أحمد ٢/٤٨، ٩٦ مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنهم)، البداية والنهاية ٨/٢٥٥ أحداث سنة أربع وستين من الهجرة، ترجمة يزيد بن معاوية، وغيرها من المصادر الكثيرة.
ثمّ قال له: ثمّ قاتلهم واستعن بالله عليهم، فإن الله ناصرك؛ إذ خالفوا الإمام، وخرجوا من الجماعة(١) .
٤٣- ولما رأى مسلم بن عقبة ضَعفَ قتال أهل الشام في قتال أهل المدينة نادى: يا أهل الشام، هذا القتال قتال قوم يريدون أن يدفعوا به عن دينهم، وأن يعزوا به نصر إمامهم؟!(٢) .
وقال أيضاً في تحريضهم على القتال: يا أهل الشام، إنّكم لستم بأفضل العرب في أحسابها ولا أنسابها، ولا أكثرها عدداً، ولا أوسعها بلداً، ولم يخصصكم الله بالذي خصّكم به - من النصر على عدوّكم، وحسن المنزلة عند أئمتكم - إلّا بطاعتكم واستقامتكم، وإنّ هؤلاء القوم وأشباههم من العرب غيّروا فغيّر الله بهم، فتمّوا على أحسن ما كنتم عليه من الطاعة يتمم الله لكم أحسن ما ينيلكم من النصر والفلج(٣) .
٤٤- ولما انتصر على أهل المدينة، واستباحها وفعل بها الأفاعيل، وانتهك الحرمات العظام، خرج إلى مكة لقتال ابن الزبير، فاحتضر في الطريق، فقال عند الموت: اللّهمّ إنّي لم أعمل عملاً قطّ بعد شهادة أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمداً عبده ورسوله، أحبّ إليّ من قتلي أهل المدينة، ولا أرجى عندي في الآخرة(٤) .
____________________
١ - تاريخ الطبري ٤/٣٧٣ أحداث سنة ثلاث وستين من الهجرة، واللفظ له، البداية والنهاية ٨/٢٤٠ أحداث سنة ثلاث وستين من الهجرة.
٢ - تاريخ الطبري ٤/٣٧٥ أحداث سنة ثلاث وستين من الهجرة، واللفظ له، جمهرة خطب العرب ٢/٣٢٧ خطبة مسلم بن عقبة يؤنب أهل الشام.
٣ - تاريخ الطبري ٤/٣٧٦ أحداث سنة ثلاث وستين من الهجرة.
٤ - تاريخ الطبري ٤/٣٨٤ أحداث سنة أربع وستين من الهجرة، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/١٢٣ أحداث سنة أربع وستين من الهجرة، ذكر مسير مسلم لحصار ابن الزبير وموته، البداية والنهاية ٨/٢٤٦ أحداث سنة أربع وستين من الهجرة، وقريب منه في الفتوح - لابن أعثم ٥/١٨٥ ذكر حرّة واقم وما قُتل فيها من المسلمين.
وقال: اللّهمّ إن عذّبتني بعد طاعتي لخليفتك يزيد بن معاوية، وقتل أهل الحرّة، فإنّي إذاً لشقي(١) .
٤٥- ثمّ قدم الحصين بن نمير مكة، فناوش ابن الزبير الحرب في الحرم، ورماه بالنيران حتى أحرق الكعبة. وكان عبد الله بن عمير الليثي قاضي ابن الزبير إذا تواقف الفريقان قام على الكعبة، فنادى بأعلى صوته: يا أهل الشام، هذا حرم الله الذي كان مأمناً في الجاهلية، يأمن فيه الطير والصيد، فاتّقوا الله يا أهل الشام. فيصيح الشاميون: الطاعة الطاعة، الكرّة الكرّة، الرواح قبل المساء. فلم يزل على ذلك حتى أُحرقت الكعبة، فقال أصحاب ابن الزبير: نطفي النار، فمنعهم وأراد أن يغضب الناس للكعبة، فقال بعض أهل الشام: إنّ الحرمة والطاعة اجتمعت، فغلبت الطاعة الحرمة(٢) .
٤٦- وقال ابن أبي الحديد: قال المسعودي: وكان عروة بن الزبير يعذر أخاه عبد الله في حصر بني هاشم في الشعب وجمعه الحطب ليحرقهم، ويقول: إنّما أراد بذلك ألاّ تنتشر الكلمة، ولا يختلف المسلمون، وأن يدخلوا في الطاعة؛ فتكون الكلمة واحدة، كما فعل عمر بن الخطاب ببني هاشم لما تأخّروا عن بيعة أبي بكر، فإنّه أحضر الحطب؛ ليحرق عليهم الدار(٣) .
____________________
١ - تاريخ اليعقوبي ٢/٢٥١ مقتل الحسين بن علي.
٢ - تاريخ اليعقوبي ٢/٢٥١ - ٢٥٢ مقتل الحسين بن علي.
٣ - شرح نهج البلاغة ٢٠/١٤٧.
ويبدو طروء التحريف والتشذيب على هذا الموضوع من كتاب مروج الذهب؛ ففي طبعة بولاق في مصر عام ١٢٨٣ هـ، ٢/٧٩، والطبعة الأولى من المطبعة الأزهرية المصرية عام ١٣٠٣ هـ الذي بهامشه تاريخ روضة المناظر في أخبار الأوائل والأواخر - للعلامة ابن شحنة ٢/٧٢، والطبعة التي بهامش الكامل ٦/١٦٠ - ١٦١ هكذا: وحدّث النوفلي في كتابه في الأخبار عن ابن عائشة، عن أبيه، عن حمّاد بن سلمة قال: كان عروة بن الزبير يعذر أخاه إذا جرى ذكر بني هاشم، وحصره إيّاهم في الشعب، =
٤٧- ولما اختلف أهل الشام بعد معاوية بن يزيد في البيعة لابن الزبير، أو لبني أُميّة خطب روح بن زنباع وجاء في جملة خطبته: وأمّا ما يذكر الناس من عبد الله بن الزبير، ويدعون إليه من أمره، فهو والله كما يذكرون بأنّه لابن الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وابن أسماء ابنة أبي بكر الصديق ذات النطاقين، وهو بعد كما تذكرون في قدمه وفضله، ولكنّ ابن الزبير منافق، قد خلع خليفتين يزيد وابنه معاوية بن يزيد، وسفك الدماء، وشقّ عصا المسلمين، وليس صاحب أمر أُمّة محمد صلى الله عليه وآله وسلم المنافق. وأمّا مروان بن الحكم فوالله ما كان في الإسلام صدع قطّ إلّا كان مروان ممّن يشعب ذلك الصدع، وهو الذي قاتل عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان يوم الدار، والذي قاتل علي بن أبي طالب يوم الجمل...(١) .
٤٨- ولما انشقّ عمرو بن سعيد الأشدق عن عبد الملك بن مروان واستولى
____________________
= وجمعه الحطب لتحريقهم، ويقول: إنّما أراد بذلك إرهابهم؛ ليدخلوا في طاعته، كما أرهب بنو هاشم وجمع لهم الحطب لإحراقهم؛ إذ هم أبوا البيعة فيما سلف. وهذا خبر لا يحتمل ذكره هنا، وقد أتينا على ذكره في كتابنا في مناقب أهل البيت وأخبارهم المترجم بكتاب حدائق الأذهان.
بينما الموجود في الطبعة الثانية من مطبعة دار السعادة بمصر عام ١٣٦٧هـ/١٩٤٨م تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ٣/٨٦، والطبعة الأولى من مطبعة دار الفكر ببيروت عام ١٤٢١هـ /٢٠٠٠م تحقيق وتعليق سعيد محمد اللحام ٣/٨٧: وحدّث النوفلي في كتابه في الأخبار عن ابن عائشة، عن أبيه، عن حمّاد بن سلمة قال: كان عروة بن الزبير يعذر أخاه إذا جرى ذكر بني هاشم وحصره إيّاهم في الشعب وجمعه لهم الحطب لتحريقهم ويقول: إنّما أراد بذلك إرهابهم؛ ليدخلوا في طاعته. إذ هم أبوا البيعة فيما سلف. وهذا خبر لا يحتمل ذكره هنا، وقد أتينا على ذكره في كتابنا في مناقب أهل البيت وأخبارهم المترجم بكتاب حدائق الأذهان.
١ - تاريخ الطبري ٤/٤١٤ أحداث سنة خمس وستين من الهجرة، ذكر السبب في البيعة لمروان بن الحكم، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/١٨٤ أحداث سنة أربع وستين من الهجرة، ذكر بيعة مروان بن الحكم، شرح نهج البلاغة ٦/١٦١.
على دمشق صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: أيّها الناس، إنّه لم يقم أحد من قريش قبلي على هذا المنبر إلّا زعم أنّ له جنة ونار، يدخل الجنّة مَنْ أطاعه والنار مَنْ عصاه. وإنّي أخبركم أنّ الجنّة والنار بيد الله، وأنّه ليس إليّ من ذلك شيء، غير أنّ لكم عليّ حسن المواساة والعطية(١) .
٤٩- وقال الوليد بن عبد الملك: أيّها الناس، عليكم بالطاعة، ولزوم الجماعة، فإنّ الشيطان مع الفرد. أيّها الناس، مَنْ أبدى لنا ذات نفسه ضربنا الذي فيه عيناه، ومَنْ سكت مات بدائه(٢) .
٥٠- ولما حاصر الحجّاج مكة المكرّمة في قتاله لابن الزبير رُميت بالمنجنيق، فرعدت السماء وبرقت، فتهيّب ذلك أهل الشام، فرفع الحجّاج بيده حجراً ووضعه في كِفّة المنجنيق، ورمى بعضهم. فلمّا أصبحوا جاءت صاعقة فقتلت من أصحاب المنجنيق اثني عشر رجلاً؛ فانكسر أهل الشام. فقال الحجّاج: يا أهل الشام، لا تنكروا ما ترون، فإنّما هي صواعق تُهامة. وعظم عندهم أمر الخلافة وطاعة الخلفاء(٣) .
٥١- وذكر الجاحظ أنّ الحجّاج قال: والله لطاعتي أوجب من طاعة الله؛ لأنّ الله تعالى يقول:( اتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ، فجعل فيها مثنوية، وقال:( وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ) ، ولم يجعل فيها مثنوية، ولو قلت لرجل: ادخل من هذا الباب، فلم
____________________
١ - تاريخ الطبري ٤/٥٩٦ - ٥٩٧ أحداث سنة تسع وستين من الهجرة، واللفظ له، تهذيب التهذيب ٨/٣٥ في ترجمة عمرو بن سعيد بن العاص.
٢ - تاريخ الطبري ٥/٢١٤ أحداث سنة ست وثمانين من الهجرة، خلافة الوليد بن عبد الملك، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/٥٢٣ أحداث سنة ست وثمانين من الهجرة، خلافة الوليد بن عبد الملك، البداية والنهاية ٩/٨٥ أحداث سنة ست وثمانين من الهجرة، خلافة الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق، تاريخ ابن خلدون ٣/٥٩ وفاة عبد الملك وبيعة الوليد، تاريخ اليعقوبي ٢/٢٨٣ أيام الوليد بن عبد الملك.
٣ - أنساب الأشراف ٧/١٢٢ أمر عبد الله بن الزبير في أيام عبد الملك ومقتله.
يدخل لحلّ لي دمه(١) .
وفي حديث الأعمش أنّ الحجّاج قال: اسمعوا وأطيعوا، ليس فيها مثنوية لأمير المؤمنين عبد الملك. والله، لو أمرت الناس أن يخرجوا من باب من أبواب المسجد، فخرجوا من باب آخر، لحلّت لي دماؤهم وأموالهم(٢) .
٥٢- وقال أبو اليقظان: بعث الحجّاج إلى الفضيل بن بزوان العدواني - وكان خيرِّاً من أهل الكوفة - فقال: إنّي أريد أن أولّيك. قال: أوَ يُعفيني الأمير؟ فأبى. وكتب عهده، فأخذه وخرج من عنده، فرمى بالعهد وهرب. فأُخِذَ وأُتي به الحجّاج، فقال: يا عدوّ الله. فقال: لست لله ولا للأمير بعدو. قال: ألم أكرمك؟ قال: بل، أردت أن تهينني. قال: ألم أستعملك؟ قال: بل أردت أن تستعبدني. قال:( إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ) ... الآية. قال: ما استوجبت واحدة منهنّ. قال: كلّ ذلك قد استوجبت بخلافك. وأمر رجلاً من أهل الشام أن يضرب عنقه(٣) .
٥٣- وقال ابن الكلبي: رأيت قاتل الحسين بن علي (عليهما السّلام) قد أُدخل على الحجّاج وعنده عنبسة بن سعيد، فقال: أأنت [قتلت] حسين؟ قال: نعم. قال: كيف؟ قال: دسرته بالرمح دسراً، وهبرته هبراً. ووكلت رأسه إلى أمر غيري. فقال الحجّاج: والله، لا يجتمعان في الجنة أبداً. فخرج أهل العراق يقولون:
____________________
١ - كتاب الحيوان للجاحظ ٣/١٥ علّة الحجّاج بن يوسف، واللفظ له، البصائر والذخائر المجلد ٢ ق ١/٢٣٠ سياسة الحجّاج، نثر الدرّ ٥/٢٣ الباب الثاني، كلام الحجّاج. ربيع الأبرار ٢/٧٩١ باب الطاعة لله ولرسوله ولولاة المسلمين، التذكرة الحمدونية ١/٣٤٠ الباب الثاني عشر ما جاء في العدل والجور.
٢ - سنن أبي داود ٢/٤٠٠ كتاب السُنّة، باب في الخلفاء، واللفظ له، البداية والنهاية ٩/١٤٨ أحداث سنة خمس وتسعين من الهجرة، ترجمة الحجّاج بن يوسف الثقفي ووفاته.
٣ - عيون الأخبار ٢/٢١٠ كتاب العلم والبيان، التلطف في الكلام والجواب وحسن التعريض، واللفظ له، أنساب الأشراف ١٣/٢٧٢ نسب عدوان.
والله، لا يجتمع ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقاتله في الجنة أبداً. وخرج أهل الشام يقولون: صدق الأمير، لا يجتمع مَنْ شقّ عصا المسلمين وخالف أمير المؤمنين وقاتِلَه في طاعة الله في الجنة(١) .
٥٢- وقد تقدّم في أوائل هذا المبحث كتاب الوليد بن يزيد بن عبد الملك لرعيته المتضمّن لتعظيم أمر طاعة الخلفاء ولزوم جماعتهم(٢) ... إلى غير ذلك ممّا يجده المتتبّع من أجل التعرّف على نظرتهم للطاعة ولزوم الجماعة وفهمهم له من دون ملاحظة لأهلية الخليفة، وسلوكه في نفسه، وسيرته في المسلمين، وعدله وجوره، بل مع التأكيد على عدم دخلها في وجوب الطاعة والحفاظ على الجماعة.
وقد بقيت السلطة وأتباعها يحاولون التذكير بهذه المفاهيم المشوهة والتأكيد عليها حتى بعد أن سقطت السلطة عن الاعتبار، وفقدت مكانتها الدينية؛ نتيجة فاجعة الطفّ ومضاعفاته، كما يظهر بأدنى ملاحظة لتاريخ المسلمين وتراثهم، ولهم في ذلك نكات ملفتة للنظر.
تبدّل موقف العباسيين من خلافة الأمويين
ومنها ما يأتي في أواخر المقام الثاني من محاولة المنصور العباسي ومَنْ بعده من حكّام بني العباس الاعتراف بشرعية خلافة الأمويين، وبوجوب طاعتهم، تأكيداً لشرعية الخلافة بالقهر والقوّة، ولترتّب وجوب الطاعة ولزوم الجماعة على الخلافة المذكورة.
مع إنّ من المعلوم أنّ دولة بني العباس قامت بناءً على عدم شرعية خلافة بني أُميّة، بل على أنّ الخلافة حق لبني هاشم، ولا شرعية لخلافة غيرهم حتى الأوّلين، كما يأتي بعض شواهد ذلك في أواخر المقام الثاني من المبحث
____________________
١ - البصائر والذخائر ٣/٤٧١، واللفظ له، نثر الدرّ - للآبي ٥/٢١ الباب الثاني، كلام الحجّاج.
٢ - تقدّم في/١٧١.
الثاني إن شاء الله تعالى(١) .
أثر هذه الثقافة على العامّة
وقد كان لهذه الثقافة تأثيرها المهم على العامّة في طاعتهم للخلفاء، بل تقديسهم لهم، لولا موقف المعارضة المضاد، ويبدو ذلك بوضوح في الشام؛ حيث اقتصر الأمر فيها على ثقافة السلطة، ولم يكن فيها للمعارضة نشاط يذكر، وقد تقدّم عرض بعض شواهد ذلك.
وحتى في إفريقية، فإنّها كانت مدّة طويلة معزولة لا يصل إليها نشاط المعارضة، ولا تعرف إلّا ثقافة السلطة.
أثر هذه الثقافة في إفريقية
ومن الطريف ما رواه الطبري بسنده عن أبي حارثة وأبي عثمان في حديثهما عن فتح إفريقية في عهد عثمان، ثمّ عن أهل إفريقية بعد الفتح، قالا: فمازالوا من أسمع أهل البلدان وأطوعهم إلى زمان هشام بن عبد الملك، أحسن أُمّة إسلاماً وطاعة حتى دبّ إليهم أهل العراق، فلمّا دبّ إليهم دعاة أهل العراق واستثاروهم، شقّوا عصاهم، وفرّقوا بينهم إلى اليوم.
وكان سبب تفريقهم أنّهم ردّوا على أهل الأهواء، فقالوا: إنّا لا نخالف الأئمّة بما تجني العمّال، ولا نحمل ذلك عليهم. فقالوا لهم: إنّما يعمل هؤلاء بأمر أولئك. فقالوا لهم: لا نقبل ذلك حتى نبورهم(٢) . فخرج ميسرة في بضعة عشر إنساناً حتى يقدم على هشام، فطلبوا الإذن، فصعب عليهم.
____________________
١ - يأتي في/٣٣١ وما بعدها.
٢ - بارَ الرجلَ: جرّبه واختبره.
فأتوا الأبرش فقالوا: أبلغ أمير المؤمنين أنّ أميرنا يغزو بنا وبجنده، فإذا أصاب نَفَلَهم دوننا، وقال: هم أحق به، فقلنا: هو أخلص لجهادنا؛ لأنّا لا نأخذ منه شيئاً. إن كان لنا فهم منه في حلّ، وإن لم يكن لنا لم نُرِده.
وقالوا: إذا حاصرنا مدينة قال: تقدّموا، وأخّر جنده، فقلنا: تقدّموا؛ فإنّه ازدياد في الجهاد، ومثلكم كفى إخوانه، فوقيناهم بأنفسنا وكفيناهم.
ثمّ إنّهم عمدوا إلى ماشيتنا فجعلوا يبقرونها عن السخال يطلبون الفراء البيض لأمير المؤمنين، فيقتلون ألف شاة في جلد، فقلنا: ما أيسر هذا لأمير المؤمنين، فاحتملنا ذلك وخليناهم وذلك.
ثمّ إنّهم سامونا أن يأخذوا كلّ جميلة من بناتنا، فقلنا: لم نجد هذا في كتاب ولا سنة، ونحن مسلمون.
فأحببنا أن نعلم أعن رأي أمير المؤمنين ذلك أم لا؟ قال: نفعل.
فلما طال عليهم، ونفدت نفقاتهم، كتبوا أسماءهم في رقاع، ورفعوها إلى الوزراء، وقالوا: هذه أسماؤنا وأنسابنا، فإن سألكم أمير المؤمنين عنّا فأخبروه.
ثمّ كان وجههم إلى إفريقية، فخرجوا على عامل هشام فقتلوه، واستولوا على إفريقية. وبلغ هشاماً الخبر، فإذا هم النفر الذين جاء الخبر أنّهم صنعوا ما صنعوا(١) .
وهو يكشف بوضوح عن تأثير هذه الثقافة في تشويه مفهوم وجوب الطاعة حتى يُتحمّل من أجلها مثل هذا الظلم، كما يكشف عن استغفال الناس - نتيجة
____________________
١ - تاريخ الطبري ٣/٣١٣ أحداث سنة سبع وعشرين من الهجرة، ذكر الخبر عن فتح أفريقية وعن سبب ولاية عبد الله بن سعد بن أبي سرح مصر وعزل عثمان عمرو بن العاص عنه، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٣/٩٢ - ٩٣ أحداث سنة سبع وعشرين من الهجرة، ذكر انتقاض افريقية وفتحها ثانية.
العوامل السابقة - حتى صاروا يحترمون هؤلاء الخلفاء الجبّارين، ويعظّمونهم هذا التعظيم مع شدّة تعلّقهم بالدنيا، وانغماسهم في الملذات بإسراف وإفساد بحيث يبلغ بهم الأمر أن يطلبوا جلد السخال البيض ولو توقف تحصيل الواحد منه على أن يبقروا بطن ألف شاة لعامّة الرعية من المسلمين.
وبدلاً من أن يأنف هؤلاء المستغفلون أن يكون هؤلاء ولاة عليهم وأمراء للمؤمنين، يحتملون ذلك ويخلون أمراءهم يفعلونه، ويقولون: ما أيسر هذا لأمير المؤمنين.
ومن الملفت للنظر أنّ الراوي لا ينعى على الخلفاء ظلمهم وظلم عمّالهم لهؤلاء، واحتجابهم عنهم بحيث لا يتسير لهم إبلاغ ظلامتهم حتى يضطرّهم ذلك لشق العصا والخروج عن طاعتهم، بعد أن كانوا - كما يقول - أحسن أُمّة إسلاماً وطاعة، بل يظهر عليه الأسف لإفساد أهل العراق ودعاتهم لهؤلاء المساكين، وحملهم على شق العصا والخروج عن الطاعة، ممّا أدّى إلى خروجهم وخلافهم بعد ما غضوا النظر عن الظلامات الكثيرة حتى بلغ الظلم إلى أعراضهم وغصب نسائهم، وبعد أن طال احتجاب الخليفة عنهم حتى نفدت نفقاتهم، وكانوا قد قصدوه من تلك المسافات البعيدة؛ ليرفعوا له ظلامتهم.
هذه هي مفاهيم الخلافة والطاعة والجماعة والفتنة وشقّ العصا التي حاولت السلطات المنحرفة نشرها بين المسلمين وتثقيفهم بها.
موقف عبد الله بن عمر من الإمامة والجماعة
وقد عُرف عن عبد الله بن عمر أنّه لا يبايع إلّا بعد اجتماع الناس على خليفة واحد من دون نظر إلى كيفية حصول الاجتماع، وأنّه هل حصل بطريق مشروع، أو بطريق عدواني غير مشروع.
وعنه أنّه قال: لا أُقاتل في الفتنة، وأصلي
وراء مَنْ غلب(١) .
وقال ابن حجر: وكان رأي ابن عمر ترك القتال في الفتنة ولو ظهر أنّ إحدى الطائفتين محقّة والأُخرى مبطلة(٢) .
وقال زيد بن أسلم: كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلّا صلّى خلفه، وأدّى إليه زكاة ماله(٣) .
وروى عبد الرزاق عن عبد الله بن محرز قال: أخبرني ميمون بن مهران قال: دخلت على ابن عمر أنا وشيخ أكبر منّي - قال: حسبت أنّه قال: ابن المسيّب - فسألته عن الصدقة أدفعها إلى الأمراء؟ فقال: نعم. قال: قلت: وإن اشتروا به الفهود والبيزان؟ قال: نعم. فقلت للشيخ حين خرجنا: تقول ما قال ابن عمر؟ قال: لا. فقلت أنا لميمون بن مهران: أتقول ما قال ابن عمر؟ قال: لا(٤) .
وروى نحو ذلك عنه غير واحد(٥) .
وقد سبق من ابن عمر أن طلب من الإمام الحسين (عليه السّلام) وعبد الله بن الزبير
____________________
١ - الطبقات الكبرى ٤/١٤٩ في ترجمة عبد الله بن عمر بن الخطاب، واللفظ له، إرواء الغليل ٢/٣٠٤.
٢ - فتح الباري ١٣/٤٠، ومثله في عمدة القاري ٢٤/٢٠٠.
٣ - الطبقات الكبرى ٤/١٤٩ في ترجمة عبد الله بن عمر بن الخطاب، واللفظ له، البداية والنهاية ٩/٨ أحداث سنة أربع وسبعين من الهجرة، في ترجمة عبد الله بن عمر، إرواء الغليل ٢/٣٠٣ - ٣٠٤.
٤ - المصنّف - لعبد الرزاق ٤/٤٧ كتاب الزكاة، باب موضع الصدقة ودفع الصدقة في مواضعه.
٥ - راجع المصنّف - لعبد الرزاق ٤/٤٦ كتاب الزكاة، باب موضع الصدقة ودفع الصدقة في مواضعه، وص ٥٠ باب لا تحل الصدقة لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والسنن الكبرى - للبيهقي ٤/١١٥ كتاب الزكاة، باب الاختيار في دفعها إلى الولي، والمصنّف - لابن أبي شيبة ٣/٤٧ كتاب الزكاة، من قال تدفع الزكاة إلى السلطان، والمجموع للنووي ٦/١٦٤، ونيل الأوطار ٤/٢٢٠، وكتاب المسند - للشافعي/٩٤، وغيرها من المصادر الكثيرة.
أن يبايعا يزيد ولا يُفرّقا جماعة المسلمين(١) .
وهو بذلك يُعطي الشرعية لخلافة مَنْ يغلب وإن كان ظالماً باغياً قد غلب على الإمارة بالقسر والإكراه والطرق الإجرامية المنحطّة.
وما أكثر ما ورد في ذلك عن السلطة وأتباعها ومَنْ سار في خطّها، وعليه جرى عملهم وسيرتهم.
الأحاديث والفتاوى في دعم هذا الاتجاه
بل حاولوا دعم ذلك بأحاديث رواها أتباع السلطة، لتكون ديناً يُتديّن به، كحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: مَنْ رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه؛ فإنّه مَنْ فارق الجماعة شبراً فمات إلّا مات ميتة جاهلية(٢) ، وغيره.
وعلى ذلك جرت فتاوى كثير من فقهاء الجمهور. قال الشوكاني تعقيباً على الحديث المذكور: فيه دليل على وجوب طاعة الأمراء وإن بلغوا في العسف والجور إلى ضرب الرعية وأخذ أموالهم، فيكون هذا مخصّصاً لعموم قوله تعالى:( مَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ) ، وقوله تعالى:( وَجَزَاء
____________________
٣ - تقدّمت مصادره في/١٩٧.
٤ - صحيح البخاري ٨/٨٧ كتاب الفتن، ما جاء في قوله تعالى:( وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّة ) ، وما كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يحذّر من الفتن، واللفظ له، صحيح مسلم ٦/٢١ كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن، السنن الكبرى - للبيهقي ٨/١٥٧ كتاب قتال أهل البغي، باب الصبر على أذى يصيبه من جهة إمامه وإنكار المنكر بقلبه وترك الخروج عليه، مسند أحمد ١/٢٧٥، ٢٩٧ مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب (رضي الله تعالى عنه)، سنن الدارمي ٢/٢٤١ كتاب الجهاد، باب لزوم الطاعة والجماعة، كتاب السنة - لابن أبي عاصم/٥١٠، مسند أبي يعلى ٤/٢٣٥، معرفة السنن والآثار ٦/٢٨٩، إرواء الغليل ٨/١٠٥، وغيرها من المصادر الكثيرة جدّاً.
سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَ ) (١) .
وقال ابن حجر: قال ابن بطال: في الحديث حجّة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلّب والجهاد معه، وأنّ طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، وحجّتهم هذا الخبر وغيره ممّا يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلّا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لِمَنْ قدر عليه...(٢) . والحديث في ذلك طويل.
مشابهة الاتجاه المذكور للتعاليم المسيحية الحالية
وهم يسيرون في ذلك باتجاه التعاليم المسيحية الشائعة الآن في الطاعة للحكام؛ فقد جاء في العهد الجديد:
لتخضع كلّ نفس للسلاطين الفائقة؛ لأنّه ليس سلطان إلّا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتّبة من الله حتى إنّ مَنْ يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة؛ فإنّ الحكّام ليسوا خوفاً للأعمال الصالحة، بل للشريرة(٢) .
حديث أمير المؤمنين (عليه السّلام) في حقوق الوالي والرعية
بينما نرى أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) يقول في خطبة له: «أمّا بعد، فقد جعل الله لي عليكم حقّاً بولاية أمركم، ولكم عليّ من الحقّ مثل الذي عليكم.
____________________
١ - نيل الأوطار ٧/٣٦٠.
٢ - فتح الباري ١٣/٥.
٣ - رسالة بولس إلى أهل رومية الإصحاح الثالث عشر: ١ - ٤.
فالحقّ أوسع الأشياء في التواصف، وأضيقها في التناصف، لا يجري لأحد إلّا جرى عليه، ولا يجري عليه إلّا جرى له...، وأعظم ما افترض الله سبحانه من تلك الحقوق حقّ الوالي على الرعية، وحقّ الرعية على الوالي، فريضة فرضها الله سبحانه لكلّ على كلّ؛ فجعلها نظاماً لأُلفتهم، وعزّاً لدينهم. فليست تصلح الرعية إلّا بصلاح الولاة، ولا تصلح الولاة إلّا باستقامة الرعية. فإذا أدّت الرعية إلى الوالي حقّه، وأدّى الوالي إليها حقّها، عزّ الحقّ بينهم وقامت مناهج الدين، واعتدلت معالم العدل...، وإذا غلبت الرعية واليها، وأجحف الوالي برعيته اختلفت هنالك الكلمة، وظهرت معالم الجور...»(١) .
ويقول في خطبة أخرى: «أيّها الناس، إنّ لي عليكم حقّ، ولكم عليّ حقّ. فأما حقّكم عليّ فالنصيحة لكم، وتوفير فيئكم عليكم، وتعليمكم كيلا تجهلوا، وتأديبكم كيما تعلموا. وأمّا حقّي عليكم فالوفاء بالبيعة، والنصيحة في المشهد والمغيب، والإجابة حين أدعوكم، والطاعة حين آمركم»(٢) .
ما تقتضيه القاعدة في البيعة
بل من الظاهر أنّ البيعة لما كانت على شروط خاصّة من العمل بالكتاب والسُنّة، والتناصح بين الوالي والرعية ونحو ذلك؛ فوجوب الوفاء بها من كلّ من الطرفين إنّما يكون مع التزامهما معاً بما اتفقا عليه، كما هو الحال في سائر العقود والعهود، ولا منشأ لوجوب التزام أحدهما بها مع عدم التزام الآخر، كما يحاول
____________________
١ - نهج البلاغة ٢/١٩٨ - ١٩٩، واللفظ له، الكافي ٨/٣٥٢.
٢ - نهج البلاغة ١/٨٤.
أتباع الانحراف في السلطة حمل الناس عليه.
ما آل إليه أمر وجوب البيعة والطاعة ولزوم الجماعة
والحاصل: إنّ وجوب بيعة الإمام وطاعته، ولزوم جماعته والنهي عن الخلاف والفتنة التي جعلها الله (عزّ وجلّ) وشرّعها من أجل نظم أمر الأُمّة، واجتماعها في دعم الحقّ، وتماسكها في وجه الباطل، قد صارت وسيلة لدعم الباطل، وانتهاك الحرمات العظام.
كحرمة مكة المكرّمة، والكعبة المعظّمة، والمدينة المنوّرة، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبره الشريف(١) ، وبيت ابنته الصديقة (عليها السّلام) الذي هو من أفاضل البيوت التي أذن الله (عزّ وجلّ) أن تُرفع ويُذكر فيها اسمه، كما في الحديث الشريف(٢) ... إلى غير ذلك من الحرّمات.
كما صارت وسيلة للوقوف في وجه رموز الدين وذوي المقام الرفيع فيه، والإيقاع بهم، كأمير المؤمنين والصديقة الزهراء (صلوات الله عليهما)، والإمام الحسين (عليه السّلام) وأهل بيته وصحبه الكرام، والمقداد بن الأسود وأبي ذرّ (رضوان الله عليهما)، ومحمد بن الحنفية وابن عباس وبقية بني هاشم في مكة المكرّمة... إلى غير ذلك ممّا تقدّم التعرّض له.
كلّ ذلك في محاولة لفرض طاعة السلطة عليهم، ومنعهم من أداء وظيفتهم في الأمر بالمعروف وإنكار المنكر، والوقوف في وجه الفساد، ومحاولة الإصلاح، والامتناع من بيعة الضلال.
____________________
١ - جوامع السيرة ١/٣٥٧ ولاية يزيد ابنه، فيض القدير ١/٥٨، السيرة الحلبية ١/٢٦٨.
٢ - تفسير الثعلبي ٧/١٠٧، شواهد التنزيل ١/٥٣٤، الدرّ المنثور ٥/٥٠، روح المعاني - للآلوسي ١٨/١٧٤، وغيرها من المصادر.
بينما نجد الإنكار لهذه المفاهيم، والردّ عليه ومحاولة تصحيحها من الخطّ الآخر. وفيهم أعلام الإسلام وذوو التقوى والمقام الرفيع في الدين. وهو الحقيق بالقبول؛ لانسجامه مع الفطرة، وموافقته للأدلّة العقلية والنقلية.
اختلاف الأُمّة في الحقّ خير من اتفاقها على الباطل
وفي الحقيقة أنّ اتفاق الأُمّة إنّما يحسن، بل يجب، إذا كان اتفاقاً على الحقّ، أمّا إذا تعذّر ذلك فاختلافها في الحقّ خير من اتفاقها على الباطل؛ لما في الاختلاف المذكور من التنبيه للحقّ والتذكير به والدعوة إليه، وجعله في متناول الطالب له.
ولو تمّ الاتفاق على الباطل لضاع الحقّ، واختفت معالمه، ولم يتيسّر لأحد الوصول إليه، وفي ذلك تفويت للغرض والحكمة الداعية لتشريع الدين الحقّ، وإرسال الأنبياء به، وجهاد المؤمنين في سبيله، وتضحياتهم الجسيمة من أجله، وربما يأتي عند الكلام في نتائج فاجعة الطفّ مزيد من التوضيح لذلك.
استعانة السلطة بالمنافقين وحديثي الإسلام
الأمر الرابع ممّا قام به الولاة في سبيل دعم سلطانهم: الاستعانة بالمنافقين وحديثي الإسلام في قيادة الجيوش، وولاية الأمصار، وتمكينهم من مقدّرات المسلمين، كما تضمّنه ما تقدّم من كلام أمير المؤمنين (عليه السّلام) في أسباب اختلاف الحديث.
وذلك إمّا لعدم تجاوب المهاجرين الأوّلين والأنصار مع السلطة، كما تعرّضنا لذلك بتفصيل في جواب السؤال الرابع من الجزء الثاني من كتابنا (في رحاب العقيدة).
وإمّا لأنّ المنافقين وحديثي الإسلام ليس لهم بأشخاصهم مكانة واحترام في نفوس عامة المسلمين، وإنّما يستمدّون حرمتهم من ارتباطهم بالسلطة، بما لها
من نفوذ واحترام في المجتمع.
وذلك يجعلهم في حاجة للالتزام بتعاليمه، والطاعة العمياء له، والحفاظ على نهجها من أجل أن تدعمهم وترفع من شأنهم، وتمكنهم في البلاد والعباد، فهم أرضية صالحة للولاء للسلطة، وأداة فاعلة في تركيز ولائها في نفوس عامة المسلمين.
مضافاً إلى أنّهم - نوعاً - يفقدون الوازع الديني الذي يمنعهم من تنفيذ تعاليم السلطة إذا انحرفت عن واقع الإسلام، ومن تركيزها بالطرق غير المشروعة، كالاستئثار بالمال، وتفضيل ذوي النفوذ في العطاء، واختلاق الأحاديث لصالحها، كما تضمّنه كلام أمير المؤمنين (عليه السّلام) السابق.
وقد ورد عن عمر بن الخطاب أنّه قال: نستعين بقوّة المنافق، وإثمه عليه(١) .
وقيل له: إنّك استعملت يزيد بن أبي سفيان، وسعيد بن العاص، ومعاوية، وفلاناً وفلاناً من المؤلّفة قلوبهم من الطلقاء وأبناء الطلقاء، وتركت أن تستعمل عليّاً والعباس والزبير وطلحة. فقال: أمّا علي فأنبه من ذلك، وأمّا هؤلاء النفر من قريش فإنّي أخاف أن ينتشروا في البلاد، فيكثروا فيها الفساد(٢) .
السلطة تمكّن للأمويين وخصوصاً معاوية
وإنّ ممّا يُلفت النظر ويدعو للتساؤل والعجب تمكين السلطة في الصدر الأوّل للأمويين من مقدّرات المسلمين وخصوصاً معاوية.
فقد كان عمر بن الخطاب يحاسب جميع ولاته سوى معاوية، حيث
____________________
١ - المصنّف - لابن أبي شيبة ٧/٢٦٩ كتاب الأمراء، ما ذكر من حديث الأمراء والدخول عليهم، واللفظ له، السنن الكبرى - للبيهقي ٩/٣٦ كتاب السير، باب من ليس للإمام أن يغزو به بحال، كنز العمّال ٤/٦١٤ ح١١٧٧٥، وقريب منه في كنز العمّال ٥/٧٧١ ح١٤٣٣٨.
٢ - شرح نهج البلاغة ٩/٢٩ - ٣٠.
كان يقول له: لا آمرك ولا أنهاك(١) . وكان يغضّ الطرف عنه وينهى عن ذمّه، ويقول: دعونا من ذمّ فتى قريش(٢) . ويقول عنه أيضاً: هذا كسرى العرب(٣) .
ويا ترى هل جاء الإسلام ليبدل كسرى فارس بكسرى العرب؟! وهل إنّ ذلك يتناسب مع ما يُنسب لعمر من خشونة العيش والتركيز على محاسبة العمّال ومنعهم من التوسّع والترف؟!
ويزيد العجب والتساؤل إذا صحّ عن عمر أنّه كان يتوقّع من معاوية الطمع وتحيّن الفرصة للاستيلاء على الخلافة؛ فقد ورد عنه أنّه حذّر أهل الشورى منه، وقال: إيّاكم والفرقة بعدي، فإن فعلتم فاعلموا أنّ معاوية بالشام، فإذا وكلتم إلى رأيكم عرف كيف يستبزّها منكم(٤) .
بل ورد عنه أنّه كان يتوقّع من بني أُميّة عامّة أن يكيدوا للإسلام. فعن
____________________
١ - الاستيعاب ٣/١٤١٧ في ترجمة معاوية بن أبي سفيان، تاريخ دمشق ٥٩/١١٢، ١١٣، ١١٤ في ترجمة معاوية بن صخر أبي سفيان، سير أعلام النبلاء ٣/١٣٣ في ترجمة معاوية بن أبي سفيان، البداية والنهاية ٨/١٣٣ أحداث سنة ستين من الهجرة النبوية، ترجمة معاوية، شرح نهج البلاغة ٨/٣٠٠، وغيرها من المصادر.
٢ - الاستيعاب ٣/١٤١٨ في ترجمة معاوية بن أبي سفيان، تاريخ دمشق ٥٩/١١٢ في ترجمة معاوية بن صخر أبي سفيان.
٣ - الاستيعاب ٣/١٤١٧ في ترجمة معاوية بن أبي سفيان، أسد الغابة ٤/٣٨٦. في ترجمة معاوية بن صخر بن حرب، الإصابة ٦/١٢١ في ترجمة معاوية بن أبي سفيان، سير أعلام النبلاء ٣/١٣٤ في ترجمة معاوية بن أبي سفيان، تاريخ دمشق ٥٩/١١٤، ١١٥ في ترجمة معاوية بن صخر أبي سفيان، البداية والنهاية ٨/١٣٤ أحداث سنة ستين من الهجرة النبوية، ترجمة معاوية. أنساب الأشراف ٥/١٥٥ في ترجمة معاوية بن أبي سفيان، وغيرها من المصادر.
٤ - الإصابة ٦/١٢٢ في ترجمة معاوية بن أبي سفيان، تاريخ دمشق ٥٩/١٢٤ في ترجمة معاوية بن صخر أبي سفيان، البداية والنهاية ٨/١٣٦ أحداث سنة ستين من الهجرة النبوية، ترجمة معاوية، وغيرها من المصادر.
المغيرة بن شعبة أنّه قال: قال لي عمر يوماً: يا مغيرة، هل أبصرت بهذه عينك العوراء منذ أُصيبت؟ قلت: لا. قال: أما والله ليُعوِرنّ بنو أُميّة الإسلام كما أعورت عينك هذه، ثمّ ليعمينّه حتى لا يدري أين يذهب ولا أين يجيء...(١) .
ظهور الاستهتار من المنافقين
وعلى كلّ حال يبدو أنّ ظهور المنافقين وحديثي الإسلام في الساحة، وفسح المجال لهم حملهم على الاستهتار، وجرّأهم على أن يبوحوا بما في نفوسهم، ويجهروا به من دون أن يراقبوا أحداً، أو يخافوا مغبّة ذلك بنحو قد يؤدّي إلى تشوّه المفاهيم المتداولة بين عامّة المسلمين.
١- فعن عائشة أنّه لما توفّي النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشرأب النفاق بالمدينة(٢) .
٢- وفي حديث حذيفة: إنّ المنافقين اليوم شرّ منهم على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا يومئذ يسرون، واليوم يجهرون(٣) .
٣- وعن أبي وائل عن حذيفة قال: قلت: يا أبا عبد الله، النفاق اليوم أكثر
____________________
١ - شرح نهج البلاغة ١٢/٨٢.
٢ - السنن الكبرى - للبيهقي ٨/١٩٩ كتاب المرتد، باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقاً كان أو غيره، معرفة السنن والآثار ٦/٣٠٤، المصنّف - لابن أبي شيبة ٨/٥٧٤ كتاب المغازي، ما جاء في خلافة عمر بن الخطاب، بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث/٢٩١، أمالي المحاملي/١٤٠، تاريخ خليفة بن خياط/٦٥ الردّة، تاريخ دمشق ٣٠/٣١١، ٣١٢، ٣١٤، ٣١٥ في ترجمة أبي بكر الصديق، فتوح البلدان ١/١١٤ خبر ردة العرب في خلافة أبي بكر الصديق، بلاغات النساء/٦ - ٧ كلام عائشة وخطبها، تاريخ الإسلام ٣/٢٨ أحداث سنة إحدى عشر من الهجرة، خبر الردّة، وغيرها من المصادر الكثيرة.
٣ - صحيح البخاري ٨/١٠٠ كتاب الفتن: باب إذا قال عند قوم شيئاً ثمّ خرج فقال بخلافه، واللفظ له، السنن الكبرى - للبيهقي ٨/٢٠٠ كتاب المرتد، باب قتل مَنْ ارتدّ عن الإسلام، المحلّى ١١/٢٢٥، وغيرها من المصادر.
أم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: فضرب بيده على جبهته وقال: أوه! وهو اليوم ظاهر، إنّهم كانوا يستخفونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم(١) .
وفي حديث آخر عن أبي وائل أنّ حذيفة قال: بل هم اليوم أكثر؛ لأنّه كان يومئذ يستسرّونه، واليوم يستعلنونه(٢) .
٤- وفي حديث آخر عن حذيفة أنّه قال: إن كان الرجل ليتكلّم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيصير منافقاً، وإنّي لأسمعها من أحدكم في المقعد الواحد أربع مرّات...(٣) .
٥- وعنه أنّه قال: إنّكم اليوم معشر العرب لتأتون أموراً إنّها لفي عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النفاق على وجهه(٤) .
٦- وعنه أيضاً أنّه قال: إنّما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمّا اليوم فإنّما هو الكفر بعد الإيمان(٥) .
٧- وقد مرّ أبو سفيان بقبر شهيد واقعة أُحد أسد الله ورسوله حمزة بن عبد المطلب (رضي الله عنه) فضربه برجله، وقال: يا أبا عمارة، إنّ الأمر الذي اجتلدنا عليه
____________________
١ - البحر الزخار المعروف بمسند البزار ٧/٣٠٣ ح٢٩٠٠ مسند حذيفة بن اليمان (رضي الله عنهم)، واللفظ له، فتح الباري ١٣/٦٤.
٢ - السنن الكبرى - للنسائي ٦/٤٩١ كتاب التفسير، سورة المنافقين.
٣ - مسند أحمد ٥/٣٩٠ حديث حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واللفظ له، المصنّف - لابن أبي شيبة ٨/٦٠٩ كتاب الفتن، من كره الخروج في الفتنة وتعوّذ عنها، مجمع الزوائد ١٠/٢٩٧ كتاب الزهد، باب في ما يحتقره الإنسان من الكلام، كتاب الزهد - لابن حنبل/٤٣، حلية الأولياء ١/٢٧٩ في ترجمة حذيفة بن اليمان، تفسير ابن كثير ٢/٣١٢، كنز العمّال ٣/٦٨٦ ح٨٤٦١.
٤ - مسند أحمد ٥/٣٩١ حديث حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واللفظ له، مجمع الزوائد ١٠/٦٤ كتاب المناقب، باب ما جاء في الكوفة.
٥ - صحيح البخاري ٨/١٠٠ كتاب الفتن، باب إذا قال عند قوم شيئاً ثمّ خرج فقال بخلافه، واللفظ له، تفسير الطبري ١٨/٢١٣، الدرّ المنثور ٥/٥٥، تفسير القرطبي ٨/٢١٤، وغيرها من المصادر.
بالسيف أمسى في يد غلماننا اليوم يتلعّبون به(١) .
٨- وكان يقول: اللّهمّ اجعل هذا الأمر أمر جاهلية، والملك ملك غاصبية، واجعل أوتاد الأرض لبني أُميّة(٢) .
٩- وعن الحسن أنّ أبا سفيان دخل على عثمان حين صارت الخلافة إليه، فقال: قد صارت إليك بعد تيم وعدي، فأدرها كالكرة واجعل أوتادها بني أُميّة؛ فإنّما هو الملك، ولا أدري ما جنة ولا نار. فصاح به عثمان: قم عنّي، فعل الله بك وفعل(٣) . قال ابن عبد البر: وله أخبار من نحو هذا ردية، ذكرها أهل الأخبار، ولم أذكرها(٤) .
وإذا كان عثمان قد صاح به في هذه الواقعة فهو - إن صحّ - لا يزيد على ردّ فعل مؤقّت من دون أن يؤثّر على علاقته به وبأولاده، ولا يمنع من تقريبهم وتمكينهم من مقدّرات الإسلام والمسلمين.
١٠- وباع معاوية سقاية من ذهب أو من ورق بأكثر من وزنه، فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن مثل هذا إلّا مثلاً بمثل. فقال معاوية: ما أرى بهذا بأساً. فقال أبو الدرداء: مَنْ يعذرني من معاوية؟! أُخبره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها. ثمّ قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) فذكر له ذلك، فكتب عمر إلى معاوية أن لا
____________________
١ - شرح نهج البلاغة ١٦/١٣٦.
٢ - تاريخ دمشق ٢٣/٤٧١ في ترجمة صخر بن حرب بن أُميّة.
٣ - الاستيعاب ٤/١٦٧٩ في ترجمة أبي سفيان صخر بن حرب، واللفظ له، النصائح الكافية/١١٠، وقريب منه في تاريخ الطبري ٨/١٨٥ أحداث سنة ٢٨٤ هـ، ومروج الذهب ٢/٣٤١ ذكر خلافة عثمان (رضي الله عنه)، قبل حديثه عن الثورة على عثمان، وأنساب الأشراف ٥/١٩ في ترجمة أبي سفيان، وتاريخ دمشق ٢٣/٤٧١ في ترجمة صخر بن حرب بن أمية، وشرح نهج البلاغة ٢/٤٥، ٩/٥٣ - ٥٤، وسبل الهدى والرشاد ١٠/٩١، وغيرها من المصادر.
٤ - الاستيعاب ٤/١٦٧٩ في ترجمة أبي سفيان صخر بن حرب.
يبيع ذلك إلّا مثلاً بمثل، وزناً بوزن(١) .
١١- كما باع معاوية الخمر(٢) .
١٢- وباع سمرة بن جندب الخمر أيضاً، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فقال: قاتل الله سمرة! ألم يعلم أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها»(٣) .
____________________
١ - السنن الكبرى - للبيهقي ٥/٢٨٠ كتاب البيوع، باب من قال الربا في الزيادة، واللفظ له، موطأ مالك ٢/٦٣٤ كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً، المجموع ١٠/٣٠، الاستذكار - لابن عبد البر ٦/٣٤٧، ٣٥٤ كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً، أضواء البيان ١/١٨٠، وغيرها من المصادر.
٢ - الرياض النضرة ٢/١٨٣ الباب الثالث في مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان (رضي الله عنه) الفصل الحادي عشر، ذكر ما نقم على عثمان مفصلاً والاعتذار عنه بحسب الإمكان، في مقتله وما يتعلّق به، الأوائل - للعسكري/١٣٠ أوّل ما وقع الاختلاف من الأُمّة فخطّأ بعضهم بعضاً حين نقموا على عثمان أشياء نحن ذاكروه.
وقد استبدل في بعض المصادر اسم معاوية بفلان راجع تاريخ دمشق ٢٦/١٩٧ في ترجمة عبادة بن الصامت، وسير أعلام النبلاء ٢/١٠ في ترجمة عبادة بن الصامت، ومسند الشاشي ٣/٤٥١ ح١١٩٦ ما روى أبو الوليد عبادة بن الصامت، في ما رواه عبيد بن رفاعة عن عبادة بن الصامت.
٣ - صحيح مسلم ٥/٤١ كتاب البيوع، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، واللفظ له، مسند أحمد ١/٢٥ مسند عمر بن الخطاب (رضي الله تعالى عنه)، السنن الكبرى - للبيهقي ٦/١٢ كتاب البيوع، باب تحريم التجارة في الخمر، السنن الكبرى - للنسائي ٣/٨٧ كتاب الفروع والعتيرة، النهي عن الانتفاع بما حرم الله (عزّ وجلّ)، ٦/٣٤٢ كتاب التفسير، تفسير سورة الأنعام، قوله تعالى:( وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَ... ) ، سنن الدارمي ٢/١١٥ كتاب الأشربة، باب في التغليظ لِمَنْ شرب الخمر، سنن ابن ماجة ٢/١١٢٢ كتاب الأشربة، باب التجارة في الخمر، صحيح ابن حبان ١٤/١٤٦ كتاب التاريخ، ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم اليهود باستعمالهم هذا الفعل، المصنّف - لعبد الرزاق ٦/٧٥ بيع الخمر، و٨/١٩٥ كتاب البيوع، باب بيع الخمر، مسند أبي يعلى ١/١٧٨ مسند عمر بن الخطاب، مسند الحميدي ١/٩، وغيرها من المصادر الكثيرة جدّاً، وروي في صحيح البخاري ٣/٤٠ كتاب البيوع، باب كم يجوز الخيار، و٤/١٤٥ كتاب بدء الخلق، إلّا إنّ فيه بدل (سمرة) (فلاناً).
١٣- وروى عائذ بن ربيعة حديث وفد بني نمير على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال في جملته: ثمّ دعا شريح واستعمله على قومه، ثمّ أمره أن يصدقهم ويزكيهم... قال: ولم يزل شريح عامل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قومه، وعامل أبي بكر، فلمّا قام عمر (رضي الله عنه) أتاه بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذه فوضعه تحت قدمه، وقال: لا، ما هو إلّا مُلك. انصرف(١) ... إلى غير ذلك، وما رواه الشيعة من ذلك كثير.
وذلك يتناسب مع ما صدر من كثير منهم من التحريف في الدين، والمواقف المشينة والأفعال الشنيعة التي تضمّنتها كتب الحديث والتاريخ والسيرة ممّا لا يسعنا استقصاؤه، وربما يأتي في حديثنا هذا الإشارة لبعضه.
موقف أُبي بن كعب وموته
ولعلّه لذا ضاقت الأمور بأُبي بن كعب، ففي حديث قيس بن عباد عنه قال: ثمّ استقبل القبلة، فقال: هلك أهل العقد - ثلاثاً - وربّ الكعبة. ثمّ قال: والله ما عليهم آسى، ولكنّي آسى على ما أضلّوا. قال: قلت: مَنْ تعني بهذا؟ قال: الأُمراء(٢) .
وقريب منه حديثه الآخر، لكن فيه: قلت: يا أبا يعقوب، ما يعني به أهل العقد؟ قال: الأُمراء(٣) . وقريب منهما أحاديث له أُخر(٤) .
____________________
١ - تاريخ المدينة ٢/٥٩٦.
٢ - المستدرك على الصحيحين ١/٢١٤ كتاب الصلاة، ومن كتاب الإمامة وصلاة الجماعة، واللفظ له. صحيح ابن خزيمة ٣/٣٣ كتاب الصلاة، باب ذكر البيان إنّ أولي الأحلام والنهي أحق بالصف الأوّل؛ إذ النبي أمر بأن يلوه، الأحاديث المختارة ٤/٢٩ - ٣٠ ما رواه قيس بن عباد البصري أبو عبد الله عن أبي بن كعب (رضي الله عنه)، موارد الظمآن ٢/٩٥ كتاب الصلاة، باب في مَنْ يلي الإمام، وغيرها من المصادر.
٣ - السنن الكبرى - للنسائي ١/٢٨٧ كتاب الإمامة والجماعة، من يلي الإمام ثمّ الذي يليه.
٤ - مسند أحمد ٥/١٤٠ حديث قيس بن عباد عن أبي بن كعب (رضي الله عنه)، شعب الإيمان ٦/١٥، =
ومثله ما عن الحسن قال: قال حذيفة: هلك أصحاب العقد وربّ الكعبة. والله ما عليهم آسى، ولكن على مَنْ يهلكون من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسيعلم الغالبون العقد خطّ [حظ. صح] مَنْ ينقصون(١) .
بل يبدو أنّه ضاق صدر أُبي بن كعب فأراد أن يجهر بالحقيقة وإن تعرّض للخطر؛ ففي حديث جندب بن عبد الله البجلي عنه قال: فسمعته يقول: هلك أصحاب العقدة وربّ الكعبة، ولا آسى عليهم، أحسبه قال مراراً...، ثمّ قال: اللّهمّ إنّي أعاهدك لئن أبقيتني إلى يوم الجمعة لأتكلّمنّ بما سمعت من رسول الله، لا أخاف فيه لومة لائم...(٢) .
وفي حديث عتي بن ضمرة عن أبي أيضاً: فقال: لئن عشت إلى هذه الجمعة لأقولنّ فيها قولاً لا أُبالي استحييتموني عليه أو قتلتموني...(٣) .
لكنّه لم يبقَ للجمعة، بل مات يوم الخميس أو يوم الجمعة، كما في تتمّة حديثي جندب بن عبد الله وعتي بن ضمرة المتقدّمين.
وعلم الله كيف مات وما سبب موته؟! إذ يبدو أنّ الوضع كان حرج خصوصاً في عهد عمر، كما يناسبه ما تقدّم في كلام أمير المؤمنين (عليه السّلام) وعثمان بن عفّان وطلحة بن عبيد الله وغيرهم عنه، والنظر في تاريخه وسيرته.
____________________
= مسند ابن الجعد/١٩٧، حلية الأولياء ١/٢٥٢ في ترجمة أبي بن كعب، تاريخ دمشق ٤٩/٤٣٦ في ترجمة قيس بن عباد.
١ - المصنّف - لعبد الرزاق ١١/٣٢٢ باب الإمام راعٍ.
٢ - الطبقات الكبرى ٣/٥٠١ في ترجمة أبي بن كعب، واللفظ له، الأحاديث المختارة ٣/٣٤٦ - ٣٤٧ ما رواه جندب أظنه ابن عبد الله بن سفيان.. عن أبي بن كعب (رضي الله عنه)، تاريخ دمشق ٧/٣٤١ في ترجمة أبي بن كعب، وغيرها من المصادر.
٣ - الطبقات الكبرى ٣/٥٠٠ - ٥٠١ في ترجمة أبي بن كعب، واللفظ له، تاريخ دمشق ٧/٣٤٠ في ترجمة أبي بن كعب، وغيرها من المصادر، تهذيب الكمال ٢/٢٧٠ في ترجمة أبي بن كعب، سير أعلام النبلاء ١/٣٩٩ في ترجمة أبي بن كعب، وغيرها من المصادر.
حتى إنّ السيد المرتضى (قدّس سرّه) حينما ذكر أنّ غرض عمر من تدبير الشورى بالوجه المعروف هو التحايل لصرف الخلافة عن أمير المؤمنين (عليه السّلام)؛ تجنّباً عن محذور التصريح بصرفها عنه (عليه السّلام)، حاول ابن أبي الحديد الردّ عليه، فقال:
فقد قلنا في جوابه ما كفى، وبيّنا أنّ عمر لو أراد ما ذكر لصرَفَ الأمر عمّن يريد صرفه عنه، ونصَّ على مَنْ يريد إيصال الأمر إليه ولم يبالِ بأحد؛ فقد عرف الناس كلّهم كيف كانت هيبته وسطوته وطاعة الرعية له حتى إنّ المسلمين أطاعوه أعظم من طاعتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، ونفوذ أمره فيهم أعظم من نفوذ أمره (عليه السّلام). فمَنْ ذا الذي كان يجسر أو يقدر أن يراجعه في نصّه، أو يرادّه، أو يلفظ - عنده أو غائباً عنه - بكلمة تنافي مراده؟!... فلقد كان أبو بكر وهو خليفة يهابه وهو رعية وسوقة بين يديه، وكلّ أفاضل الصحابة كان يهابه وهو بعد لم يلِ الخلافة...، فمَنْ كانت هذه حاله وهو رعية وسوقة فكيف يكون وهو خليفة قد ملك مشارق الأرض ومغاربها، وخطب له على مئة ألف منبر؟!...(١) .
تبرير السلطة بعض مواقفها بالقضاء والقدر
وزاد في تعقّد الأمر محاولة السلطة وأتباعها الاعتذار عن بعض مواقفهم الخاطئة وتبريرها بالقضاء والقدر، وكأنّه قضاء قهري يكفي في العذر ورفع المسؤولية.
فعن ابن عباس في حديث له مع عمر عندما خرج إلى الشام أنّه قال: فقال لي: يابن عباس، أشكو إليك ابن عمّك، سألته أن يخرج معي فلم يفعل، ولم أزل أراه واجداً، فيم تظنّ موجدته؟ قلت: يا أمير المؤمنين، إنّك لتعلم. قال:
____________________
١ - شرح نهج البلاغة ١٢/٢٨٠ - ٢٨١.
أظنّه لا يزال كئيباً لفوت الخلافة. قلت: هو ذاك؛ إنّه يزعم أنّ رسول الله أراد الأمر له. فقال: يابن عباس، وأراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمر له فكان ماذا إذا لم يُرد الله تعالى ذلك؟! إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أراد أمراً، وأراد الله غيره فنفذ مراد الله تعالى، ولم ينفذ مراد رسوله، أوَ كلّما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان؟!...(١) .
وقال الطبري في الحديث عن مقتل عمر والشورى: «فخرجوا ثمّ راحوا، فقالوا: يا أمير المؤمنين، لو عهدت إلينا عهداً. فقال: قد كنت أجمعت بعد مقالتي لكم أن أنظر فأولّي رجلاً أمركم، هو أحراكم أن يحملكم على الحقّ - وأشار إلى علي - ورهقتني غشية، فرأيت رجلاً يدخل جنّة قد غرسها، فجعل يقطف كلّ غضّة ويانعة فيضمّها إليه ويصيّرها تحته، فعلمت أنّ الله غالب على أمره ومتوفٍّ عمر، فما أريد أن أتحمّلها حيّاً وميّتاً، عليكم هؤلاء الرهط...». ثمّ ذكر تدبير عمر في الشورى بما هو معروف مشهور(٢) .
فانظر إليه كيف جعل رؤياه مطابقة لقضاء الله تعالى وقدره، ومبرّراً لتركه في اختيار مَنْ هو أحرى أن يحملهم على الحقّ وتدبير أمر الشورى، مع إنّ من المظنون - إن لم يكن من المعلوم - أنّه يؤدّي إلى خلافة عثمان الذي تفرّس فيه أن يلي الخلافة، فيحمل بني أُميّة وبني أبي معيط على رقاب الناس(٣) .
وقد استمرت السلطة على تأكيد هذا المفهوم حتى تبلورت عقيدة الجبر وظهرت في جمهور المسلمين، والحديث في ذلك طويل لا يسعنا استقصاؤه.
____________________
١ - شرح نهج البلاغة ١٢/٧٨ - ٧٩.
٢ - تاريخ الطبري ٣/٢٩٣ أحداث سنة ثلاث وعشرين من الهجرة، قصّة الشورى.
٣ - الاستيعاب ٣/١١١٩ في ترجمة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، تاريخ دمشق ٤٤/٤٣٩ في ترجمة عمر بن الخطاب، تاريخ المدينة ٣/٨٨١، ٨٨٣، ٨٨٤، تاريخ اليعقوبي ٢/١٥٨ أيام عمر بن الخطاب، كنز العمّال ٥/٧٣٨ ح ١٤٢٦٢، وص ٧٤١ ح ١٤٢٦٦، شرح نهج البلاغة ١/١٨٦، بحار الأنوار ٦/٣٢٦، و١٢/٥٢، ٢٥٩، و٣١/٣٩٤، وغيرها من المصادر.
قيام كيان الإسلام العام على الطاعة العمياء للسلطة
إذا عرفت هذا فمن الطبيعي أن ينشأ المسلمون - بعد تلك الفتوح الكبرى، وانتشار الإسلام الواسع، ودخول مَنْ لا عهد له بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعاليمه - على ذلك، ويبتني كيانهم العام عليه.
وكان نتيجته تشوّه المفاهيم الإسلامية التي تشيع عند عامّة المسلمين، واحترام السلطة كيف كانت، وتحكّم غير المعصوم في الدين، يحلّ ما يشاء، ويحرّم ما يشاء، ويبتدع ما يشاء من دون أن يحيط بأحكام الدين ويعرفها معرفة كاملة، ولا أن يلتزم بحرفية التشريع ويتقيّد به.
والمفروض على المسلمين القبول منه، والطاعة له، واللزوم لجماعته، والرضا بما قضى الله (عزّ وجلّ) من دون اعتراض على الحاكم.
وفي حديث بين عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس حول مَنْ يستخلفه بعده جاء فيه: يابن عباس، أترى صاحبكم لها موضعاً؟ قال: فقلت: وأين يبتعد من ذلك مع فضله وسابقته وقرابته وعلمه؟! قال: هو والله كما ذكرت، ولو وليهم لحملهم على منهج الطريق، فأخذ المحجّة الواضحة...، والله يابن عباس، إنّ عليّاً ابن عمّك لأحقّ الناس به، ولكنّ قريشاً لا تحتمله، ولئن وليهم ليأخذنهم بمرّ الحقّ لا يجدون عنده رخصة، ولئن فعل لينكثنّ بيعته ثمّ ليتحاربَنّ(١) .
حيث يبدو من ذلك بوضوح أنّ اتّجاه السلطة كان نحو التحلّل من قيود الدين، وافتعال الرخص، وعدم الالتزام بمرّ الحقّ؛ إرضاءً لقريش التي دخل أكثرها في الإسلام خوفاً أو طمعاً من دون أن يستحكم في نفوسها كعقيدة ثابتة
____________________
١ - تاريخ اليعقوبي ٢/١٥٨ - ١٥٩ أيام عمر بن الخطاب.
بحيث تجري على تعاليمه وإن خالف أهواءها.
تعرّض الدين للتحريف
وبذلك تعرّض الدين للتحريف عن جهل أو عمد كما قال أبو موسى الأشعري: لقد ذكّرنا علي بن أبي طالب صلاة كنّا نصلّيها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ إمّا نسيناه، وإمّا تركناها عمداً...(١) . وقريب منه عن عمران بن حصين(٢) .
وفي حديث أبي الدرداء: والله، ما أعرف من أُمّة محمد صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً إلّا إنّهم يصلّون جميعاً(٣) . وفي حديث أنس قال: ما أعرف شيئاً ممّا كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قيل: الصلاة. قال: أليس ضيّعتم ما ضيّعتم فيها؟(٤) ... إلى غير ذلك.
وقد عانى الإسلام نتيجة ذلك من أمور ثلاثة:
جهل المتصدّين للفتوى والقضاء
الأمر الأوّل: جهل المتصدّين لبيان الأحكام في الفتوى والقضاء حيث لا ينتظر من الحاكم غير المعصوم أن يلتزم بالرجوع للمعصوم والإرجاع له،
____________________
١ - مسند أحمد ٤/٣٩٢، واللفظ له، ٤٠٠، ٤١٢، ٤١٥ حديث أبي موسى الأشعري (رضي الله عنه)، المصنّف - لابن أبي شيبة ١/٢٧٢ كتاب الصلوات، مَنْ كان يتم التكبير ولا ينقصه في كلّ رفع وخفض، علل الدارقطني ٧/٢٢٤، فتح الباري ٢/٢٢٤، عمدة القاريء ٦/٥٨ - ٥٩، تفسير القرطبي ١/١٧٢، شرح معاني الآثار ١/٢٢١، التمهيد - لابن عبد البرج ٩/١٧٦، وغيرها من المصادر الكثيرة.
٢- صحيح البخاري ج: ١ ص: ١٩٠، ٢٠٠. صحيح مسلم ج: ٢ ص: ٨.
٣ - صحيح البخاري ١/١٥٩ كتاب الجماعة والإمامة، باب فضل صلاة الجماعة، واللفظ له، مسند أحمد ٥/١٩٥ باقي حديث أبي الدرداء، شرح صحيح مسلم - للنووي ١٦/١٧٥، وغيرها من المصادر.
٤ - صحيح البخاري ١/١٣٤ كتاب مواقيت الصلاة، باب تضييع الصلاة عن وقته، ونحوه في الكافي ٨/٦٤.
والتقيد بفتواه وقضائه.
خصوصاً بعد ما سبق من تشوّه المفاهيم التي يبتني عليها المجتمع الإسلامي للطاعة ولزوم الجماعة والفرقة والفتنة.
وبعد ما هو المعلوم من كون المعصوم خصماً للسلطة، وقد غُيّب - بما له من مقام رفيع وما يحمله من مفاهيم أصيلة - عن الكيان الإسلامي العام.
ومن الطبيعي حينئذ أن يفسح الحاكم المجال لكلّ مَنْ يتعاون معه، أو يسير في ركابه مهما كانت ثقافته الدينية وتمرّسه في القضاء، خصوصاً مع سعة رقعة الإسلام نتيجة الفتوح، والحاجة للتكثير من القضاة والمفتين.
ظهور الاختلاف في الحديث والقضاء والفتوى
وبذلك ظهر الاختلاف في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما هو المعلوم بالرجوع لمصادره، وقد تضمنه الحديث السابق عن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في بيان أسباب اختلاف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم(١) .
كما شاع الاختلاف بين القضاة والمفتين مع قربهم من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم(٢) ، بل كثيراً ما تختلف فتاوى أو قضاء الشخص الواحد في المسألة الواحدة(٣) .
____________________
١ - تقدّم في/١٧٩ - ١٨١.
٢ - ومن مفردات ذلك ما تجده في صحيح مسلم ٥/١٢٥ كتاب الحدود، باب حد الخمر، ومسند أحمد ٣/١١٥ مسند أنس بن مالك، وسنن الدارمي ٢/٣٥٤ كتاب الفرائض: باب قول عمر في الجد، والسنن الكبرى - للبيهقي ٦/٢٤٧ كتاب الفرائض، باب من ورث الإخوة للأب والأُمّ أو الأب مع الجد، ومسند أبي يعلى ٥/٣٦٨ ح ٣٠١٥، وغيرها من المصادر الكثيرة.
٣ - ومن مفردات ذلك ما تجده في السنن الكبرى - للبيهقي ٦/٢٥٥ كتاب الفرائض، باب المشركة، والمصنّف - لابن أبي شيبة ٧/٣٣٤ كتاب الفرائض، ومعرفة السنن والآثار ٥/٧١ كتاب الفرائض، باب المشركة، المصنّف - لعبد الرزاق ١٠/٢٦٢ كتاب الفرائض، باب فرض الجد، وغيرها من المصادر.
من دون التزام - مع كلّ ذلك - برفع الاختلاف وتصحيح الخطّ؛ لعدم الاعتراف بالمرجع المعصوم من جهة، وعدم الاهتمام بتوحيد الفتوى وتصحيح الخطأ من جهة أخرى، بل مع إقرار كلّ على ما يقول، بنحو يوحي باحترام أشخاص المفتين والقضاة المنسجمين مع السلطة على حساب الحقّ والحكم الشرعي الواحد.
كلام أمير المؤمنين (عليه السّلام) حول اختلاف القضاء
يقول أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسّلام): «ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه، ثمّ ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافه، ثمّ يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوّب آراءهم جميعاً، وإلههم واحد، ونبيّهم واحد، وكتابهم واحد.
أفأمرهم الله تعالى بالاختلاف فأطاعوه؟! أم نهاهم عنه فعصوه؟! أم أنزل ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه؟! أو كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى؟! أم أنزل الله سبحانه ديناً فقصّر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن تبليغه وأدائه، والله سبحانه يقول:( مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ) ...»(٢) .
وبالمناسبة روي عن حفص بن عمر، قال: كان عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) إذا كثر عليه الخصوم صرفهم إلى زيد، فلقي رجلاً ممّن صرفه إلى زيد، فقال له: ما
____________________
٢ - نهج البلاغة ١/٥٤ - ٥٥.
صنعت؟
قال: قضى عليّ يا أمير المؤمنين.
قال: لو كنت أنا لقضيت لك.
قال: فما يمنعك وأنت أولى بالأمر؟
قال: لو كنت أردّك إلى كتاب الله أو سُنّة نبيّه فعلت، ولكنّي إنّما أردّك إلى رأي، والرأي مشير(١) .
ظهور الجرأة على الفتوى والقضاء
ومن الطبيعي أن يفرز ذلك الجرأة على الفتوى والحكم والتسامح فيهم، والاعتزاز بالرأي والإصرار عليه، وشيوع الاختلاف، وفقد الضوابط في التعرّف على الدين وتعاليمه وأحكامه، وفي التصدّي للفتوى والمرجعية فيه، وفي جميع شؤون الدين من الأصول والفروع.
ولاسيما إنّ الكتاب المجيد لا يتيسّر لعموم الناس معرفة تفاصيل الأحكام منه، وإنّه صالح للتأويل على وجوه مختلفة ولو كانت متكلّفة.
وقد يتشبث بها مَنْ يتعصّب لوجهة نظر خاصة ويسير في خطّه، أو يحاول الظهور ويحبّ السمعة؛ دعماً لرأيه وإصراراً عليه.
كما إنّ السُنّة الشريفة قد ابتُليت بالضياع على عامّة الناس - نتيجة ما سبق من تحجير السلطة عليها -، وبالآفات التي سبق من أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) التعرّض لها في وجه اختلاف الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم(٢) .
شكوى أمير المؤمنين (عليه السّلام) من أوضاع الأُمّة
ويبدو تفاقم المشكلة من خطبة لأمير المؤمنين (عليه السّلام)، قال فيها: «وما كلّ ذي قلب بلبيب، ولا كلّ ذي سمع بسميع، ولا كلّ ناظر ببصير، فيا عجبي
____________________
١ - تاريخ المدينة ٢/٦٩٣.
٢ - تقدّم كلامه (عليه السّلام) في/١٧٩ - ١٨١.
ـ وما لي لا أعجب - من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينه، لا يقتصّون أثر نبي، ولا يقتدون بعمل وصي، ولا يؤمنون بغيب، ولا يعفون عن عيب. يعملون في الشبهات، ويسيرون في الشهوات. المعروف عندهم ما عرفوا، والمنكر عندهم ما أنكروا. مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم، وتعويلهم في المبهمات على آرائهم، كأنّ كلّ امرئ منهم إمام نفسه، قد أخذ منها فيما يرى بعرىً ثِقات، وأسباب محكمات»(١) .
وقد حقّق ذلك الأرضية الصالحة لانقسام الأُمّة، وظهور الفرق في الإسلام التي بدأت بالخوارج، وتتابعت من بعدهم حتى يومنا هذا. وإنّا لله وإنّا إليه راجعون. والحديث في ذلك طويل نقتصر منه على ما ذكرنا.
ظهور الابتداع في الدين ومخالفة نصوصه
الأمر الثاني: ظهور الابتداع في الدين ومخالفة نصوصه وتجاوزه كما يتّضح ذلك بالرجوع لما ذكره أهل الحديث وعلماء الكلام والمؤرّخون.
والناس على دين ملوكهم يأخذونه منهم، بل كثيراً ما لا يهتّمون بمعرفة دينهم والتقيّد به، أو يقدّمون طاعتهم على ما يعرفون من دينهم، وقد تقدّم عند التعرّض لتركيز السلطة على وجوب الطاعة بعض مفردات ذلك.
ويأتي إن شاء الله تعالى في المقام الأوّل من المبحث الثاني كلام لأمير المؤمنين (صلوات الله عليه) يتعرّض فيه لبعض تلك المخالفات والبدع(٢) .
____________________
١ - نهج البلاغة ١/١٥٥ - ١٥٦.
٢ - يأتي في/٢٧٥ وما بعده.
تشويه الحقائق في التاريخ والمناقب والمثالب
الأمر الثالث: تشويه الحقائق في التاريخ والسيرة، وفي المناقب والمثالب كما أشرنا إلى بعضه عند الكلام في ألقاب التشريف التي أُطلقت على الحكّام ومَنْ سار على خطّهم، وفي التحجير على السُنّة النبويّة الشريفة وغير ذلك ممّا تقدّم، وقد يأتي ما ينفع في المقام.
ظهور حجم الخطر بملاحظة ثقافة الأمويين
ويمكن أن نعرف خطورة ما كانت تصل إليه الأمور لو بقيت الأمور على ذلك - من دون إصلاح في مسار السلطة، أو معارضة تقف في وجهه، وإنكار يكبح جماحها - ممّا انتهى إليه الأمر أيام الحكم الأموي.
حيث صفت للأمويين - ولاءً وتثقيفاً - الشام التي هي مركز ثقل قوّتهم، ولم تكن لهم فيها معارضة ظاهرة، واستطاعوا أن يعمّموا ثقافتهم فيها للمناطق النائية عن مواقع المعارضة وتأثيرها كما تقدّم شيء منه عند التعرّض لموقف أهل إفريقية(١) .
نماذج من التحريف في العهد الأموي
فإنّه يبدو مدى تشويه المفاهيم، والتحريف في الدين والتعتيم على الحقائق وتجاهله وقلبه من أفعالهم وتصريحاتهم وتصريحات عمّالهم وأتباعهم حتى في بقيّة بلاد المسلمين؛ استهواناً بالمعارضة، وتحدّياً لشعور المسلمين فيه.
١- فقد سبق من معاوية قوله: الأرض لله، وأنا خليفة الله، فما أخذت فلي، وما تركته للناس فبفضل منّي(٢) .
____________________
١ - راجع/٢٠٥.
٢ - تقدّمت مصادره في/١٦٧.
٢- ولما دخل معاوية الكوفة بعد صلح الإمام الحسن (عليه السّلام) معه، وبايعه الناس دخل عليه هاني بن الخطاب الهمداني، أو سعيد بن الأسود بن جبلة الكندي، فقال: أبايعك على كتاب الله وسُنّة نبيّه.
فقال له معاوية: ولا شرط لك.
لكنّ الرجل قال له: وأنت أيضاً فلا بيعة لك.
فتراجع معاوية وقال: إذاً فبايع، فما خير شيء ليس فيه كتاب الله وسُنّة نبيّه(١) .
٣- كما صلّى معاوية صلاة الجمعة يوم الأربعاء(٢) .
٤- واتّخذ لعن أمير المؤمنين سُنّة في الدين حتى ورد أنّه إذا تركها بعضهم صاح الناس تركت السُنّة(٣) .
وقال محمد بن عقيل: أجمع أهل حمص في زمنٍ ما على أنّ الجمعة لا تصح بغير لعن أبي تراب (عليه السّلام)(٤) .
وقال عمرو بن شعيب: ويل للأُمّة! رفعت الجمعة، وتركت اللعنة، وذهبت السُنّة(٥) .
____________________
١ - أنساب الأشراف ٣/٢٨٨ - ٢٨٩ أمر الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام)، واللفظ له، تاريخ دمشق ٥٢/٣٨٠ في ترجمة محمد بن خالد بن أمة.
٢ - مروج الذهب ٣/٤١ ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان، النصائح الكافية/١١٦، العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل/٥٦.
٣ - النصائح الكافية/١١٦.
٤ - النصائح الكافية/١١٦.
٥ - مناقب آل أبي طالب - لابن شهرآشوب ٣/٢٢.
وقال الشجري: لما أسقط عمر بن عبد العزيز (رحمه الله تعالى) من الخطب على المنابر لعن أمير المؤمنين (عليه السّلام)، قام إليه عمرو بن شعيب وقد بلغ إلى الموضع الذي كانت بنو أُميّة تلعن فيه علياً (عليه السّلام) فقرأ مكانه:( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ ) ، فقام إليه عمرو بن شعيب (لعنه الله)، فقال: يا أمير المؤمنين، السُنّة السُنّة، يحرّضه على لعنه [كذا في المصدر] علي (عليه السّلام).
فقال عمر: اسكت، قبّحك الله! تلك البدعة لا السُنّة.
وتمم خطبته. الأمالي - للشجري ١/١٥٣ الحديث السابع، فضل أهل البيت (عليهم السّلام) كافة وما يتّصل بذلك.
ولمّا خطب الخطيب بذلك في جامع صنعاء قام إليه ابن محفوظ، وقال: قطعت السُنّة.
قال: بل هي البدعة.
فقال: لأنهضنّ إلى الشام، فإن وجدت الخليفة قد عزم على قطعها لأضرمنّ الشام عليه ناراً.
لكنّه لما خرج تبعه أهل صنعاء فرجموه بالحجارة حتى غمروه وبغلته بها(١) .
٥- واستلحق زياد بن سُميّة المولود على فراش عبد ثقيف بشهادة أبي مريم السلولي بزنا أبي سفيان بسُميّة(٢) ؛ تحدّياً لسُنّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتّفق عليها بين المسلمين حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»(٣) . ونزعاً للحياء، واستهتاراً بالقيم والمثل كما أشار إلى ذلك الشاعر بقوله:
ألا أبلغ معاويةَ بن حرب |
مغلغلةً من الرجلِ اليماني |
|
أتغضبُ أن يُقالَ أبوكَ عفّ |
وترضى أن يُقالَ أبوك زانِ(٤) |
____________________
١ - غاية الأماني في أخبار القطر اليماني/١١٧ في أحداث سنة ٩٩ من الهجرة.
٢ - الكامل في التاريخ ٣/٤٤٤ أحداث سنة أربع وأربعين من الهجرة، ذكر استلحاق معاوية زياد، شرح نهج البلاغة ١٦/١٨٧، مروج الذهب ٣/١٦ ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان، الحقّ زياد بأبي سفيان، خزانة الأدب ٦/٥٠، النصائح الكافية/٨١.
٣ - صحيح البخاري ٣/٥ كتاب البيوع، باب الحلال بيّن والحرام بيّن، وص ٣٩ باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه، وص ١٨٧ كتاب الوصايا، باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي وما يجوز للوصي من الدعوى، و٥/٩٦ كتاب المغازي، باب غزوة الفتح، و٨/٩ كتاب الفرائض، باب الولد للفراش حرّة كانت أو أمة، وغيره، صحيح مسلم ٤/١٧١ كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقّي الشبهات، سنن ابن ماجة ١/٦٤٦ باب الولد للفراش وللعاهر الحجر، وغيرها من المصادر الكثيرة.
٤ - تاريخ الطبري ٤/٢٣٥ أحداث سنة تسع وخمسين من الهجرة، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٣/٥٢٣ أحداث سنة تسع وخمسين من الهجرة، ذكر هجاء يزيد بن مفرغ الحميري، الاستيعاب ٢/٥٢٧ في ترجمة زياد بن أبي سفيان، تاريخ دمشق ٣٤/٣١٤ في ترجمة عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص، و٦٥/١٨٠ - ١٨١ في ترجمة يزيد بن زياد بن ربيعة، وفيات الأعيان ٦/٣٥٠ في ترجمة يزيد بن مفرغ الحميري، البداية والنهاية ٨/١٠٣ أحداث سنة تسع وخمسين من الهجرة، قصة يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري، وغيرها من المصادر.
٦- وورد أنّ المغيرة بن شعبة قال لمعاوية: إنّك قد بلغت سناً يا أمير المؤمنين، فلو أظهرت عدلاً، وبسطت خيراً؛ فإنّك قد كبرت، ولو نظرت إلى إخوتك من بني هاشم فوصلت أرحامهم، فوالله ما عندهم اليوم شيء تخافه، وإنّ ذلك ممّا يبقى لك ذكره وثوابه.
فقال له: هيهات! أيّ ذكر أرجو بقاءه؟! مَلَك أخو تيم فعدل وفعل ما فعل، فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره إلّا أن يقول قائل: أبو بكر، ثمّ مَلَك أخو عدي فاجتهد وشمّر عشر سنين، فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره إلّا أن يقول قائل: عمر، وإنّ ابن أبي كبشة ليُصاح به كلّ يوم خمس مرّات: أشهد أنّ محمداً رسول الله، فأيّ عمل يبقى، وأيّ ذكر يدوم بعد هذا لا أباً لك؟! لا والله، إلّا دفناً دفناً(١) .
٧- وأمر معاوية بمنبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحمل من المدينة إلى الشام، وقال: لا يترك وعصا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة وهم قتلة عثمان.
فحُرّك المنبر فكُسفت الشمس حتى رؤيت النجوم بادية؛ فأعظم الناس ذلك فتركه(٢) .
٨- ولما ولي عبد الملك همّ بنقله أيضاً فذُكر له ذلك فتركه(٣) .
____________________
١ - شرح نهج البلاغة ٥/١٣٠، النصائح الكافية/١٢٤، مروج الذهب ٤/٤٤ - ٤٥ ذكر خلافة المأمون وجمل من أخباره وسيره ولمع ممّا كان في أيامه، المأمون وحديث معاوية.
٢ - الكامل في التاريخ ٣/٤٦٣ - ٤٦٤ أحداث سنة خمسين من الهجرة، ذكر إرادة معاوية نقل المنبر من المدينة، واللفظ له، تاريخ الطبري ٤/١٧٧ أحداث سنة خمسين من الهجرة، إمتاع الأسماع ١٠/١٠٨ فصل في ذكر منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وغيرها من المصادر.
٣ - تاريخ الطبري ٤/١٧٧ - ١٧٨ أحداث سنة خمسين من الهجرة، الكامل في التاريخ ٣/٤٦٤ أحداث سنة خمسين من الهجرة، ذكر إرادة معاوية نقل المنبر من المدينة، إمتاع الأسماع ١٠/١٠٩ فصل في ذكر منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وغيرها من المصادر.
٩- وكذلك الوليد بن عبد الملك(١) .
١٠- وفي حديث عباد بن عبد الله بن الزبير قال: لما قدم علينا معاوية حاجّاً قدمنا معه مكة، قال: فصلّى بنا الظهر ركعتين، ثمّ انصرف إلى دار الندوة، وقال: وكان عثمان حين أتمّ الصلاة إذا قدم مكّة صلّى بها الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعاً أربعاً، فإذا خرج إلى منى وعرفات قصّر الصلاة، فإذا فرغ من الحجّ وأقام بمنى أتمّ الصلاة حتى يخرج من مكّة، فلمّا صلّى بنا الظهر ركعتين نهض إليه مروان بن الحكم وعمرو بن عثمان فقالا له: ما عاب أحد ابن عمّك بأقبح ما عبته به.
فقال لهما: وما ذاك؟
قال: فقالا له: ألم تعلم أنّه أتمّ الصلاة بمكّة؟
قال: فقال لهما: ويحكما! وهل كان غير ما صنعت؟ قد صلّيتهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع أبي بكر وعمر (رضي الله عنهم).
قالا: فإن ابن عمّك قد كان أتمّها، وإنّ خلافك إيّاه له عيب.
قال: فخرج معاوية فصلاّها بنا أربعاً(٢) .
حيث يبدو مدى استهوانه بأحكام الإسلام وبالمسلمين من تبدّل موقفه السريع، وتفريقه في القصر والإتمام بين صلاتين ليس بينهما فارق زمني طويل.
١١- ومعاوية أوّل مَنْ اتّخذ المقصورة في الصلاة(٣) .
____________________
١ - الكامل في التاريخ ٣/٤٦٤ أحداث سنة خمسين من الهجرة، ذكر إرادة معاوية نقل المنبر من المدينة، واللفظ له، تاريخ الطبري ٤/١٧٧ - ١٧٨ أحداث سنة خمسين من الهجرة، إمتاع الأسماع ١٠/١٠٩ فصل في ذكر منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وغيرها من المصادر.
٢ - مسند أحمد ٤/٩٤ حديث معاوية بن أبي سفيان، واللفظ له، مجمع الزوائد ٢/١٥٦ - ١٥٧ كتاب الصلاة، باب في مَنْ أتمّ الصلاة في السفر، وذكر بعضه في فتح الباري ٢/٤٧١، وعمدة القارىء ٧/١٣٤، وتحفة الأحوذي ٣/٨٧، ونيل الأوطار ٣/٢٥٩، وغيرها من المصادر.
٣ - الكامل في التاريخ ٣/٤٤٦ أحداث سنة أربع وأربعين من الهجرة، البداية والنهاية ٧/٣٦٥ أحداث سنة أربعين من الهجرة، صفة مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، المعارف - لابن قتيبة/٥٥٣، أنساب الأشراف ٣/٢٥٢ أمر ابن ملجم وأمر أصحابه ومقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السّلام)، وغيرها من المصادر.
١٢- وهو أوّل مَنْ قعد في الخطبة(١) . وعن ابن أبي رؤبة الدباس أنّ بني أُميّة كانوا يقعدون في إحدى خطبتي العيد والجمعة ويقومون في الأخرى(٢) .
١٣- ولما أراد عمرو بن سعيد الأشدق عامل يزيد بن معاوية على المدينة أن يبعث جيشاً إلى عبد الله بن الزبير في مكة المكرّمة قال له أبو شريح: لا تغزُ مكّة؛ فإنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إنّما أذن لي في القتال بمكة ساعة من نهار، ثمّ عادت كحرمتها». فأبى عمرو أن يسمع قوله، وقال: نحن أعلم بحرمتها منك أيّها الشيخ(٣) .
١٤- ولما استولى عبد الله بن الزبير على السلطة في الحجاز منع عبد الملك بن مروان أهل الشام من حجّ بيت الله الحرام، واستبدله بحجّ بيت المقدس(٤) .
١٥- وكان الوليد بن يزيد يصلّي - إذا صلّى أوقات إفاقته من السكر - إلى
____________________
١ - السنن الكبرى - للبيهقي ٣/١٩٧ كتاب الجمعة، باب الخطبة قائم، المصنّف - لابن أبي شيبة ٢/٢١ كتاب الجمعة، من كان يخطب قائم، فتح الباري ٣/٣٣٣، عمدة القاريء ٦/٢١٩، عون المعبود ٣/٣١٠، نيل الأوطار ٣/٣٣٠، سبل السلام ٢/٤٧، فقه السنة ١/٣١١، الدرّ المنثور ٦/٢٢٢، تاريخ دمشق ٥٩/٢٠٢ في ترجمة معاوية بن أبي سفيان، البداية والنهاية ٨/١٤٨ أحداث سنة ستين من الهجرة، ترجمة معاوية بن أبي سفيان، وغيرها من المصادر الكثيرة.
٢ - شرح نهج البلاغة ١٥/٢٤٠.
٣ - تاريخ الطبري ٤/٢٥٧ أحداث سنة ستين من الهجرة، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/١٨ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر عزل الوليد عن المدينة وولاية عمرو بن سعيد، تاريخ ابن خلدون ٣/٢١ عزل الوليد عن المدينة وولاية عمر بن سعيد، ونحوه في مسند أحمد ٤/٣٢ حديث أبي شريح الخزاعي (رضي الله عنه)، وشرح معاني الآثار ٣/٣٢٧، والسيرة النبوية - لابن هشام ٤/٨٧٣، وتاريخ دمشق ٤٦/٣٨ في ترجمة عمرو بن سعيد بن العاص، والبداية والنهاية ٤/٣٥٠، وغيرها من المصادر الكثيرة.
٤ - البداية والنهاية ٨/٣٠٨ أحداث سنة ستة وستين من الهجرة، تاريخ اليعقوبي ٢/٢٦١ أيام مروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير، وفيات الأعيان ٣/٧٢ في ترجمة عبد الله بن الزبير، حياة الحيوان/١١٩ في مادة أوز، خلافة الوليد بن عبد الملك، وغيرها من المصادر.
غير القبلة، فقيل له في ذلك. فقرأ:( فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) (١) .
١٦- وكان الحجّاج - عامل عبد الملك بن مروان وابنه الوليد - مستهتراً بالدين والمسلمين، وهو الذي سمّى المدينة المنوّرة: أُمّ نتن، وأساء إلى أهلها، وقال: أنتم قتلة أمير المؤمنين عثمان...(٢) .
وذكر الذين يزورون قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: تبّاً لهم! إنّما يطوفون بأعواد ورِمة بالية، هلاّ طافوا بقصر أمير المؤمنين عبد الملك، ألا يعلمون أنّ خليفة المرء خير من رسوله؟!(٣) .
١٧- وكذلك خالد بن عبد الله القسري عامل سليمان بن عبد الملك حيث أجرى الماء العذب لأهل مكّة من أجل أن يستبدلوا بها عن زمزم، وخطب الناس فقال: أيّها الناس، أيّهما أعظم أخليفة الرجل على أهله أم رسوله إليهم؟ والله لو لم تعلموا فضل الخليفة إلّا أنّ إبراهيم خليل الرحمن استسقى فسقاه
____________________
١ - شرح نهج البلاغة ١٥/٢٤٢.
٢ - الكامل في التاريخ ٤/٣٥٨ - ٣٥٩ أحداث سنة ثلاث وسبعين من الهجرة، ذكر قتل ابن الزبير، أنساب الأشراف ٧/١٣٦ أمر عبد الله بن الزبير في أيام عبد الملك ومقتله، نهاية الأرب في فنون الأدب ٢١/٨٩ أحداث سنة ثلاث وسبعين من الهجرة، ذكر مبايعة أهل مكة عبد الملك بن مروان وما فعله الحجّاج من هدم الكعبة وبنائها ومسيره إلى المدينة وما فعله فيها بالصحابة (رضي الله عنهم).
٣ - شرح نهج البلاغة ١٥/٢٤٢، واللفظ له، النصائح الكافية/١٠٦، وقد روي المقطع الأوّل من قوله: إنّما يطوفون بأعواد ورمة بالية. في إمتاع الأسماع ١٢/٢٥٩، والعقد الفريد ٥/٥١ كتاب اليتيمة الثانية، فرش كتاب أخبار زياد والحجّاج والطالبيين والبرامكة، أخبار الحجّاج، مَنْ زعم أنّ الحجّاج كان كافراً، وحياة الحيوان/١١٩ في مادة أوز، خلافة الوليد بن عبد الملك، ونثر الدرّ ٥/٢٣ الباب الثاني، كلام الحجّاج، وغيرها من المصادر.
وقد روي ما يقرب من المقطع الأخير من كلامه: خليفة المرء خير من رسوله. في سنن أبي داود ٢/٤٠٠ كتاب السُنّة، باب في الخلفاء، وعون المعبود ١٢/٢٥٦، وتاريخ دمشق ١٢/١٥٨ في ترجم الحجّاج بن يوسف، والبداية والنهاية ٩/١٥١ أحداث سنة خمس وتسعين من الهجرة، في ترجمة الحجّاج بن يوسف الثقفي، وغيرها من المصادر.
ملحاً أُجاجأً، واستسقاه الخليفة فسقاه عذباً فراتاً(١) .
وخطب أيضاً فقال: قد جئتكم بماء الغادية لا يشبه ماء أُمّ الخنافس، يعني زمزم(٢) .
وكان يقول: والله، لأمير المؤمنين أكرم على الله من أنبيائه(٣) .
وقال: أيّما أكرم عندكم على الرجل، رسوله في حاجته، أو خليفته في أهله؟ يعرض بأنّ هشاماً خير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم(٤) .
وكان يقول حين أخذ سعيد بن جبير وطلق بن حبيب بمكة: كأنّكم أنكرتم ما صنعت؟! والله، لو كتب إليّ أمير المؤمنين أن أنقضها حجراً حجراً لفعلت، يعني الكعبة المعظّمة(٥) .
وأمر خالد ببناء بيعة لأُمّه فكُلّم في ذلك. فقال: نعم يبنونه. فلعنهم
____________________
١ - تاريخ الطبري ٥/٢٢٥ أحداث سنة تسع وثمانين من الهجرة، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/٥٣٦ أحداث سنة تسع وثمانين من الهجرة، ذكر ولاية خالد بن عبد الله القسري مكة، البداية والنهاية ٩/٩٢ أحداث سنة تسع وثمانين من الهجرة، تاريخ الإسلام ٦/٣٥ أحداث سنة تسع وثمانين من الهجرة، أخبار مكة ٣/٦٠ ذكر منبر مكة وأوّل من جعله وكيف كانوا يخطبون بمكة قبل أن يتخذ المنبر ومَنْ خطب عليه، الأغاني ٢٢/١٧ في أخبار خالد بن عبد الله، يتطاول على مقام النبوّة، وغيرها من المصادر.
٢ - أنساب الأشراف ٩/٥٨ في أمر خالد بن عبد الله القسري وغيره من ولاة العراق في أيام هشام، واللفظ له، تاريخ دمشق ١٦/١٦١ في ترجمة خالد بن عبد الله بن يزيد، سير أعلام النبلاء ٥/٤٢٩ في ترجمة القسري، بغية الطلب في تاريخ حلب ٧/٣٠٨٥ في ترجمة خالد بن عبد الله بن يزيد، وقريب منه في الروض المعطار في خبر الأقطار ١/٢٩٣ في الكلام عن زمزم.
٣ - الأغاني ٢٢/١٧ في أخبار خالد بن عبد الله، يتطاول على مقام النبوّة.
٤ - الأغاني ٢٢/١٧ - ١٨ في أخبار خالد بن عبد الله، يتطاول على مقام النبوّة، وقريب منه في الكامل في التاريخ ٥/٢٨٠ أحداث سنة ست وعشرين ومئة من الهجرة، ذكر قتل خالد بن عبد الله القسري.
٥ - أنساب الأشراف ٩/٥٩ في أمر خالد بن عبد الله القسري وغيره من ولاة العراق في أيام هشام، واللفظ له، تاريخ دمشق ١٦/١٦١ في ترجمة خالد بن عبد الله بن يزيد، سير أعلام النبلاء ٥/٤٢٩ في ترجمة القسري، بغية الطلب في تاريخ حلب ٧/٣٠٨٥ في ترجمة خالد بن عبد الله بن يزيد، الأغاني ٢٢/١٧ في أخبار خالد بن عبد الله يتطاول على مقام النبوّة، وغيرها من المصادر.
الله إن كان دينها شرّاً من دينكم(١) . واتّخذ كنيسة لأُمّه في قصر الإمارة...، وأمر المؤذّنين أن لا يؤذّنوا حتى يضرب النصارى بنواقيسهم(٢) ... إلى غير ذلك ممّا يدلّ على استخفافه بالدين.
١٨- وذكر ابن عائشة أنّ خالد بن سلمة بن العاص بن هشام المخزومي المعروف بالفأفاء كان ينشد بني مروان الأشعار التي هُجي بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم(٣) .
١٩- وفي حديث جابر الجعفي عن زيد بن علي بن الحسين (عليهم السّلام) في أمر خروجه قال: يا جابر، لا يسعني أن أسكن وقد خولف كتاب الله، وتحوكم إلى الجبت والطاغوت؛ وذلك أنّي شهدت هشاماً ورجل عنده يسبّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت للسّاب: ويلك يا كافر! أما إنّي لو تمكّنت منك لاختطفت روحك وعجّلتك إلى النار. فقال لي هشام: مه عن جليسنا يا زيد...(٤) .
٢٠- وكان بنو أُميّة في ملكهم يؤذّنون ويقيمون في صلاة العيد(٥) . وروي أنّ أوّل مَنْ أحدثه منهم معاوية(٦) .
____________________
١ - أنساب الأشراف ٩/٦٠ في أمر خالد بن عبد الله القسري وغيره من ولاة العراق في أيام هشام، ونظيره في الكامل في التاريخ ٥/٢٨٠ أحداث سنة ست وعشرين ومئة من الهجرة، ذكر قتل خالد بن عبد الله القسري.
٢ - أنساب الأشراف ٩/٦٣ في أمر خالد بن عبد الله القسري وغيره من ولاة العراق في أيام هشام، وقريب منه في الأغاني ٢٢/١٤ في أخبار خالد بن عبد الله، يتطاول على مقام النبوّة.
٣ - تهذيب التهذيب ٣/٨٤ في ترجمة خالد بن سلمة بن العاص، العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل/٩٣ باب تعديل الفسّاق.
٤ - مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/١١٣.
٥ - شرح نهج البلاغة ١٥/٢٤٠، المحلّى ٥/٨٢ صلاة العيدين، مسألة ٥٤٣، الاستذكار - لابن عبد البر ٢/٣٧٨ كتاب العيدين، باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة، تاريخ الطبري ٦/٢٦ أحداث سنة تسع وعشرين ومئة من الهجرة، الكامل في التاريخ ٥/٣٥٩ أحداث سنة تسع وعشرين ومئة من الهجرة، وغيرها من المصادر.
٦، المصنّف - لابن أبي شيبة ٢/٧٥ كتاب صلاة العيدين، مَنْ قال ليس في العيدين أذان ولا إقامة، =
٢١- وقد قدموا الخطبة في صلاة العيد أيضاً. وأوّل مَنْ قام بذلك عثمان(١) ، أو معاوية(٢) ، أو مروان(٣) ، وروي أنّه سبقهم إلى ذلك عمر بن الخطاب(٤) .
٢٢- كما كان بنو أُميّة يبيعون الرجل في الدين يلزمه، وعقوبة على جرم منه، ويرون أنّه يصير رقيقاً. قال ابن أبي رؤبة الدباس في كتاب افتراق هاشم وعبد شمس: كان معن أبو عمير بن معن الكاتب حرّاً مولى لبني العنبر، فبيع في دين عليه فاشتراه أبو سعيد بن زياد بن عمرو العتكي، وباع الحجّاج علي بن بشير بن الماحوز - لكونه قتل رسول المهلّب - على رجل من الأزد(٥) .
____________________
= و٨/٣٢٨ كتاب الأوائل، باب أوّل ما فعل ومن فعله، نيل الأوطار ٣/٣٦٤، عمدة القاريء ٦/٢٨٢، فيض القدير ٥/٢٦٨، سبل السلام ٢/٦٧، تحفة الأحوذي ٣/٦٢، وغيرها من المصادر الكثيرة.
١ - المصنّف - لعبد الرزاق ٣/٢٨٤ كتاب صلاة العيدين، باب أوّل مَنْ خطب ثمّ صلّى، نيل الأوطار ٣/٣٦٢ كتاب العيدين، باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وما يُقرأ فيه.
٢ - المصنّف - لعبد الرزاق ٣/٢٨٤ كتاب صلاة العيدين، باب أوّل مَنْ خطب ثمّ صلّى، فتح الباري ٢/٣٧٦، نيل الأوطار ٣/٣٦٣ كتاب العيدين، باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وما يُقرأ فيه، سبل السلام ٢/٦٦ كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين، وغيرها من المصادر.
٣ - المصنّف - لعبد الرزاق ٣/٢٨٥ كتاب صلاة العيدين، باب أوّل مَنْ خطب ثمّ صلّى، المصنّف - لابن أبي شيبة ٢/٧٧ كتاب صلاة العيدين، مَنْ رخّص أن يخطب قبل الصلاة، نيل الأوطار ٣/٣٦٣ كتاب العيدين، باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وما يُقرأ فيه، وغيرها من المصادر.
٤ - فقد روي عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: أوّل مَنْ بدأ بالخطبة قبل الصلاة يوم الفطر عمر بن الخطاب لما رأى الناس ينقصون، فلمّا صلّى حبسهم في الخطبة، المصنّف - لعبد الرزاق ٣/٢٨٣ كتاب صلاة العيدين، باب أوّل مَنْ خطب ثمّ صلّى، وقريب منه في المصنّف - لابن أبي شيبة ٢/٧٧ كتاب صلاة العيدين، مَنْ رخّص أن يخطب قبل الصلاة، وقد نبّه إلى ذلك في نيل الأوطار ٣/٣٦٣ كتاب العيدين، باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وما يُقرأ فيه.
٥ - شرح نهج البلاغة ١٥/٢٤٢.
٢٣- وكانوا يسبون ذراري الخوارج وغيرهم، ويسترقّونهم كما تُسترقّ الكفّار. قال ابن أبي رؤبة الدباس في كتابه المذكور: لما قُتل قريب وزحاف الخارجيان سبى زياد ذراريهم، فأعطى شقيق بن ثور السدوسي إحدى بناتهم، وأعطى عباد بن حصين الأخرى.
وسُبيت بنت لعبيدة بن هلال اليشكري، وبنت لقطري بن فجاءة المازني، فصارت هذه إلى العباس بن الوليد بن عبد الملك، واسمها أُمّ سلمة، فوطئها بملك اليمين على رأيهم، فولدت له المؤمّل ومحمداً وإبراهيم وأحمد وحصيناً بني عباس بن الوليد بن عبد الملك.
وسُبي واصل بن عمرو القن واستُرق، وسُبي سعيد الصغير الحروري واستُرق، وأُمّ يزيد بن عمر بن هبيرة، وكانت من سبي عمان الذين سباهم مجاعة(١) .
وقال ابن أعثم عن واقعة العقر حيث حارب بنو مروان بني المهلّب بقيادة مسلمة بن عبد الملك: ثمّ حلف مسلمة أنّه يبيع نساءهم وأولادهم بيع العبيد والإماء. فقام إليه الجراح بن عبد الله الحكمي، فقال: أصلح الله الأمير، فإنّي قد اشتريتهم منك بمئة ألف درهم؛ تبرئة ليمينك. فقال مسلمة أخزاه الله: قد بعتك إيّاهم. قال: ثمّ استحى مسلمة أن يبيع قوماً أحرار. فقال للجراح: أقلني من بيعتي. قال: قد أقلتك أيّها الأمير، فأعتقهم مسلمة وخلّى سبيلهم، وألحقهم بقومهم بالبصرة(٢) .
ويناسب ذلك من معاوية أمران:
____________________
١ - شرح نهج البلاغة ١٥/٢٤١ - ٢٤٢.
٢ - الفتوح - لابن أعثم ٨/٢٥٧ خلافة يزيد بن عبد الملك، ذكر فتنة يزيد بالبصرة ومبايعة يزيد بن المهلّب.
الأوّل: إنّه في حرب صفين نذر في سبي نساء ربيعة وقتل المقاتلة، فقال في ذلك خالد بن المعمر:
تمنّى ابن حربٍ نذرة في نسائنا |
ودونَ الذي ينوي سيوف قواضبِ |
|
ونمنحُ ملكاً أنتَ حاولتَ خلعه |
بني هاشم قولُ امرئ غيرُ كاذبِ(١) |
الثاني : إنّه بعد التحكيم بعث بسر بن أرطاة مُغيراً على الحرمين واليمن، فأغار على همدان وسبى نساءهم فكنّ أوّل نساء مسبيّات في الإسلام(٢) .
وعن أبي رباب وصاحب له أنّهما سمعا أبا ذرّ (رضي الله عنه) يدعو ويتعوّذ في صلاة صلاها، أطال قيامها وركوعها وسجودها. قال: فسألناه مِمَّ تعوّذت وفيمَ دعوت؟ فقال: تعوّذت بالله من يوم البلاء ويوم العورة. فقلنا: وما ذاك؟ قال: أمّا يوم البلاء فتلتقي فتيان [فئتان] من المسلمين فيقتل بعضهم بعضاً، وأمّا يوم العورة فإنّ نساءً من المسلمات ليسبينّ، فيُكشف عن سوقهنّ، فأيّتهنّ كانت أعظم ساقاً اشتُريت على عظم ساقها؛ فدعوت الله أن لا يدركني هذا الزمان، ولعلّكما تدركانه. قال: فقُتل عثمان، ثمّ أرسل معاوية بسر بن أرطاة إلى اليمن فسبى نساءً مسلمات فأقمنَ في السوق(٣) .
كما يناسب ذلك أيضاً من ابنه يزيد أمران:
____________________
١ - وقعة صفين/٢٩٤.
٢ - الاستيعاب ١/١٦١ في ترجمة بسر بن أرطأة، أسد الغابة ١/١٨٠ في ترجمة بسر بن أرطأة، الوافي بالوفيات ١٠/٨١ في ترجمة بسر بن أرطأة.
٣ - الاستيعاب ١/١٦١ في ترجمة بسر بن أرطأة، واللفظ له، المصنّف - لابن أبي شيبة ٨/٦٧٢ كتاب المغازي، ما ذكر في فتنة الدجّال، الوافي بالوفيات ١٠/٨١ - ٨٢ في ترجمة بسر بن أرطأة، ونحوه مختصراً في تاريخ الإسلام ٥/٣٦٩ في ترجمة بسر بن أبي أرطأة.
الأوّل : ما جرى منه مع عائلة الإمام الحسين (صلوات الله عليه). فعن فاطمة بنت الإمام الحسين (عليه السّلام) أنّها قالت: لما أُدخلنا على يزيد ساءه ما رأى من سوء حالنا... قالت: فقام إليه رجل من أهل الشام أحمر، وقال له: يا أمير المؤمنين، هبّ لي هذه الجارية، يعنيني... فارتعدت وفرقت، وظننت أن ذلك يجوز لهم، فأخذت بثياب أُختي وعمّتي زينب. فقالت عمّتي: كذبت والله ولؤمت، ما ذلك لك ولا له. فغضب يزيد وقال: بل أنتِ كذبتِ، إنّ ذلك لي، ولو شئت فعلته. قالت: كلاّ والله ما جعل لك ذلك، إلّا أن تخرج من ملّتنا، وتدين بغير ديننا.
فقال: إيّاي تستقبلين بهذا؟! إنّما خرج من الدين أبوكِ وأخوكِ. قالت زينب: بدين الله ودين أبي وجدّي اهتديت إن كنت مسلماً. فقال: كذبتِ يا عدوّة الله. قالت زينب: أمير مسلّط يشتم ظالماً، ويقهر بسلطانه. اللّهمّ إليك أشكو دون غيرك. فاستحيى يزيد، وندم وسكت مطرقاً.
وعاد الشامي إلى مثل كلامه... فقال له يزيد: اعزب عنّي لعنك الله، ووهب لك حتفاً قاضياً! ويلك لا تقل ذلك؛ فهذه بنت علي وفاطمة، وهم أهل بيت لم يزالوا مبغضين لنا منذ كانوا(١) .
الثاني : ما حصل من قائد جيشه في المدينة المنوّرة بعد واقعة الحرّة حيث
____________________
١ - مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٦٢، واللفظ له، الإرشاد ٢/١٢١، إعلام الورى بأعلام الهدى ١/٤٧٤ - ٤٧٥ الباب الثاني، الفصل الرابع، مثير الأحزان/٨٠، وغيرها من المصادر.
وأُسندت الحادثة لفاطمة بنت أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في الأمالي - للصدوق/٢٣١ المجلس الحادي والثلاثون، وتاريخ الطبري ٤/٣٥٣ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، والكامل في التاريخ ٤/٨٦ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، والبداية والنهاية ٨/٢١١ - ٢١٢ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، وتاريخ دمشق ٦٩/١٧٦ - ١٧٧ في ترجمة زينب الكبرى بنت علي بن أبي طالب، وغيرها من المصادر.
أخذ الناس بالبيعة على أنّهم عبيد ليزيد(١) .
وقد سبقهم إلى ذلك خالد بن الوليد حيث سبى في أوّل خلافة أبي بكر بني حنيفة قوم مالك بن نويرة بعد أن قتله في قضية مشهورة.
لكنّ ذلك أحدث لغطاً بين المسلمين، فلمّا قدم متمم بن نويرة على أبي بكر يطلب بدم أخيه، ويسأله أن يردّ عليهم سبيهم، ودى أبو بكر مالكاً من بيت المال وأمر بردّ السبي(٢) .
هذا وربما يجد المتتبع كثيراً من مفردات تحكّم الأمويين في الدين وتحريفهم له، ولا يسعنا فعلاً استقصاء ذلك.
٢٤- ومن شواهد تعتيمهم على الحقائق وتشويهها وقلبها ما روي من أنّ عمر بن عبد العزيز كان يلعن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)، فسمعه معلّمه مرّة فقال له: متى علمت أنّ الله سخط على أهل بدر بعد أن رضي عنهم؟! فقال له عمر: وهل كان علي من أهل بدر؟ قال: ويحك! وهل كانت بدر كلّها إلّا له؟!(٣) .
____________________
١ - تقدّمت مصادره في/١٢٦.
٢ - الكامل في التاريخ ٢/٣٥٩ أحداث سنة إحدى عشرة من الهجرة، ذكر مالك بن نويرة، إمتاع الأسماع ١٤/٢٤٠، تاريخ دمشق ١٦/٢٥٧ في ترجمة خالد بن الوليد، تاريخ الإسلام ١/٣٧ مقتل مالك بن نويرة، وص ٣٧٧ في ترجمة خالد بن الوليد، الإصابة ٥/٥٦٠ في ترجمة مالك بن نويرة، تاريخ الطبري ٢/٥٠٣ أحداث السنة الحادية عشرة من الهجرة، ذكر البطاح وخبره، شرح نهج البلاغة ١٧/٢٠٦ - ٢٠٧، سير أعلام النبلاء ١/٣٧٧ في ترجمة خالد بن الوليد، وغيرها من المصادر الكثيرة.
وقريب منه في أسد الغابة ٤/٢٩٦ في ترجمة مالك بن نويرة، وتاريخ خليفة بن خياط/٦٨ أحداث سنة إحدى عشر من الهجرة، الردّة، وتاريخ دمشق ١٦/٢٥٦ في ترجمة خالد بن الوليد، وغيرها من المصادر.
٣ - شرح نهج البلاغة ٤/٥٨ - ٥٩، وقد ذكر مختصراً في تاريخ دمشق ٤٥/١٣٦ في ترجمة عمر بن عبد العزيز، وسير أعلام النبلاء ٥/١١٧ في ترجمة عمر بن عبد العزيز، وتاريخ الإسلام =
٢٥- وحين حضرت وفود الأنصار بباب معاوية، وخرج إليهم حاجبه سعد أبو درّة، قال له: استأذن لنا. فدخل، وقال لمعاوية: الأنصار بالباب. وكان عنده عمرو بن العاص فضاق بهذا اللقب الذي عرفوا به نتيجة جهودهم العظيمة في نصر الإسلام، وثبت لهم في الكتاب المجيد والسنة الشريفة، وقال لمعاوية: ما هذا اللقب الذي جعلوه نسباً؟! أرددهم إلى نسبهم.
فقال معاوية: إنّ علينا في ذلك شناعة. قال: وما في ذلك؟! إنّما هي كلمة مكان كلمة، ولا مردّ له. فقال له معاوية: اخرج فنادِ: مَنْ بالباب من ولد عمرو بن عامر فليدخل. فخرج فنادى بذلك، فدخل مَنْ كان هناك منهم سوى الأنصار. فقال له: اخرج فنادِ: مَنْ كان ههنا من الأوس والخزرج فليدخل. فخرج فنادى ذلك. فوثب النعمان بن بشير فأنشأ يقول:
يا سعدُ لا تُعِدِ الدعاءَ فما لنا |
نسبٌ نجيبُ به سوى الأنصارِ |
|
نسبٌ تخيّرهُ الإلهُ لقومنا |
أثقِل به نسباً على الكفّارِ |
|
إنّ الذينَ ثووا ببدرٍ منكم |
يومَ القليبِ هم وقودُ النارِ |
وقام مغضباً فانصرف. فبعث معاوية فردّه وترضّاه، وقضى حوائجه وحوائج مَنْ حضر معه من الأنصار(١) .
٢٦- ومرّ سليمان بن عبد الملك بالمدينة - وهو ولي عهد - فأمر أبان بن عثمان أن يكتب له سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومغازيه، فقال أبان: هي عندي قد أخذتها مصحّحة ممّن أثق به. فأمر بنسخه، وألقى فيها إلى عشرة من الكتاب فكتبوها في رق، فلمّا صارت إليه نظر، فإذا فيها ذكر الأنصار في العقبتين، وذكر الأنصار
____________________
= ٧/١٨٨ في ترجمة عمر بن عبد العزيز، والوافي بالوفيات ٢٢/٣١٢ في ترجمة عمر بن عبد العزيز، والبداية والنهاية ٩/٢١٨ أحداث سنة إحدى ومئة من الهجرة، في ترجمة عمر بن عبد العزيز، والسيرة الحلبية ٢/٤٧٠، وغيرها من المصادر.
١ - الأغاني ١٦/٤٨ أخبار النعمان بن بشير ونسبه، الأنصار خير ألقاب أهل المدينة.
في بدر، فقال: ما كنت أرى لهؤلاء القوم هذا الفضل. فإمّا أن يكون أهل بيتي غمصوا عليهم، وإمّا أن يكونوا ليس هكذا...، ما حاجتي إلى أن أنسخ ذاك حتى أذكره لأمير المؤمنين، لعلّه يخالفه؟! فأمر بذلك الكتاب فخُرّق.
ولما رجع إلى أبيه أخبره، فقال عبد الملك: وما حاجتك أن تقدم بكتاب ليس لنا فيه فضل؟! تريد أن تُعرِّف أهل الشام أموراً لا نريد أن يعرفوها؟! قال سليمان: فلذلك يا أمير المؤمنين أمرت بتخريق ما كنت نسخته... فصوّب رأيه(١) .
٢٧- وقال إسماعيل بن عياش: سمعت حريز بن عثمان يقول: هذا الذي يرويه الناس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال لعلي: «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى» حق، ولكن أخطأ السامع. قلت: فما هو؟ قال: إنّما هو أنت منّي بمنزلة قارون من موسى. قلت: عمّن ترويه؟ قال: سمعت الوليد بن عبد الملك يقوله وهو على المنبر(٢) .
٢٨- وحكى الأزدي في الضعفاء أنّ حريزاً هذا روى أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يركب بغلته جاء علي بن أبي طالب فحلّ حزام البغلة؛ ليقع النبي صلى الله عليه وآله وسلم(٣) .
٢٩- وعن أبي يحيى السكري قال: دخلت مسجد دمشق فرأيت في مسجدها خلقاً، فقلت: هذا بلد قد دخله جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
____________________
١ - الموفقيات/٣٣١ - ٣٣٣ خبر أبان بن عثمان يكتب سير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومغازيه.
٢ - تهذيب التهذيب ٢/٢٠٩ في ترجمة حريز بن عثمان، واللفظ له، تهذيب الكمال ٥/٥٧٧ في ترجمة حريز بن عثمان، تاريخ بغداد ٨/٢٦٢ في ترجمة حريز بن عثمان، تاريخ دمشق ١٢/٣٤٩ في ترجمة حريز بن عثمان، تاريخ الإسلام ١٠/١٢٢ في ترجمة حريز بن عثمان، النصائح الكافية/١١٧، وغيرها من المصادر.
٣ - تهذيب التهذيب ٢/٢٠٩ - ٢١٠ في ترجمة حريز بن عثمان، واللفظ له، الضعفاء والمتروكين - لابن الجوزي ١/١٩٧ في ترجمة حريز بن عثمان، النصائح الكافية/١١٧، وغيرها من المصادر.
وعليهم، وملت إلى حلقة في المسجد في صدرها شيخ جالس فجلست إليه، فسأله رجل ممّن بين يديه، فقال: يا أبا المهلّب، مَنْ علي بن أبي طالب؟! قال: خنّاق، كان بالعراق، اجتمعت إليه جميعة فقصد أمير المؤمنين يحاربه فنصره الله عليه.
قال: فاستعظمت ذلك وقمت، فرأيت في جانب المسجد شيخاً يصلّي إلى سارية، حسن السمت والصلاة والهيئة، فقعدت إليه، فقلت له: يا شيخ، أنا رجل من أهل العراق، جلست إلى تلك الحلقة، وقصصت عليه القصّة. فقال لي: في هذا المسجد عجائب، بلغني أنّ بعضهم يطعن على أبي محمد حجّاج بن يوسف، فعلي بن أبي طالب مَنْ هو؟!(١) .
٣٠- وعن معمر أنّه قال: دخلت مسجد حمص، فإذا أنا بقوم لهم رواء فظننت بهم الخير؛ فجلست إليهم، فإذا هم ينتقصون علي بن أبي طالب ويقعون فيه، فقمت من عندهم فإذا شيخ يصلّي ظننت به خير؛ فجلست إليه. فلمّا حسّ بي جلس وسلّم، فقلت له: يا عبد الله، ما ترى هؤلاء القوم يشتمون علي بن أبي طالب وينتقصونه؟! وجعلت أحدّثه بمناقب علي بن أبي طالب، وأنّه زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبو الحسن والحسين، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: يا عبد الله، ما لقي الناس من الناس، لو أنّ أحداً نجا من الناس لنجا منهم أبو محمد (رحمه الله)، هو ذا يُشتم ويُنتقص. قلت: ومَنْ أبو محمد؟! قال: الحجّاج بن يوسف (رحمه الله). وجعل يبكي. فقمت عنه، وقلت: لا أستحلّ أن أبيت به؛ فخرجت من يومي(٢) .
٣١- ولما سقطت الدولة الأموية أرسل عبد الله بن علي مشيخة من أهل الشام لأبي العباس السفّاح، فحلفوا له أنّهم لا يعرفون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قرابة غير
____________________
١ - تاريخ دمشق ١/٣٦٥ باب ذكر ما ورد في ذم أهل الشام وبيان بطلانه عند ذوي الأفهام.
٢ - تاريخ دمشق ١/٣٦٦ باب ذكر ما ورد في ذم أهل الشام وبيان بطلانه عند ذوي الأفهام.
بني أُميّة(١) .
٣٢- ومن ذلك رفعهم من شأن الخلفاء، وأن الله عز وجل لا يحاسبهم على أعمالهم ولا يؤاخذهم بها.
مثل ما يأتي في حديث أبي عبيد الله، قال: «دخلت على أبي جعفر المنصور يوماً، فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء، فاحلف بالله أنك تصدقني... فحلفت، فقال: ما قولك في خلفاء بني أمية؟ فقلت: وما عسيت أن أقول فيهم. إنه من كان منهم لله مطيعاً، وبكتابه عاملاً، ولسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم متبعاً، فإنه إمام يجب طاعته ومناصحته، ومن منهم على غير ذلك فلا. فقال: جئت بها - والذي نفسي بيده - عراقية. هكذا أدركت أشياخك من أهل الشام يقولون؟ قلت: لا، أدركتهم يقولون: إن الخليفة إذا استخلف غفر الله له ما مضى من ذنوبه. فقال لي المنصور: إي والله، وما تأخر من ذنوبه...»(٢) .
وفي حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: «لما توفي عمر بن عبد العزيز وولي يزيد بن عبد الملك قال: سيروا بسيرة عمر. قال: فأتي بأربعين شيخاً فشهدوا له ما على الخلفاء حساب ولا عذاب»(٣) .
وأمّا وضع الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره في عهدهم فهو أشهر من أن يحتاج إلى بيان، ويأتي التعرّض لطرف منه في المقام الثاني من المبحث الثاني إن شاء الله تعالى.
____________________
١ - سير أعلام النبلاء ٦/٧٩ في ترجمة السفّاح، وفيات الأعيان ٦/١٠١ - ١٠٢ في ترجمة هلال بن المحسن الصابئ، شرح نهج البلاغة ٧/١٥٩، وغيرها من المصادر.
٢- يأتي الحديث بتمامه مع مصادره في ص: ٣٣٤ - ٣٣٥.
٣- تاريخ مدينة دمشق ج: ٦٥ ص: ٣٠٤ في ترجمة يزيد بن عبد الملك بن مروان، واللفظ له. تاريخ الإسلام ج: ٧ ص: ٢٨٠ في ترجمة يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم. تاريخ الخلفاء ص: ٢٤٦ في ترجمة يزيد بن عبد الملك بن مروان. وغيرها من المصادر.
ولا ينبغي أن يستُغرب شيء من ذلك بعد فتح هذا الباب من اليوم الأوّل كما سبق، وبعد النظر لواقع الحكّام واهتماماتهم، والقياس على بقيّة الأديان السماوية الحقّة التي انطمست معالمها وتاريخها الصحيح نتيجة تحكّم السلطة فيها، أو تحكّم المؤسسات التي تنسّق مع السلطة.
هذا ما تيسّر لنا التعرّض له في بيان ما من شأنه أن يترتّب على انحراف أمر السلطة في الإسلام لو لم تكن هناك معارضة، وجهود تقف في وجه الانحراف وتكبح جماحه.
والظاهر أنا لم نعطِ الموضوع حقّه، ولم نستوفِ ما حصل، وبمزيد من الفحص تتّضح كثير من الشواهد والمؤيّدات لما سبق، ومن الله (عزّ وجلّ) نستمدّ العون والتوفيق.
المبحث الثاني
في جهود أهل البيت عليهم السلام في كبح جماح الانحراف
وما كسبه الإسلام بكيانه العام من ذلك
والكلام تارة: في جهود أمير المؤمنين الإمام علي (صلوات الله عليه) وجهود الخاصّة من الصحابة والتابعين الذين كانوا معه.
وأُخرى: في مواجهة معاوية لجهود أمير المؤمنين (عليه السّلام) بعد استيلائه على السلطة بعد مقتل أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسّلام)، وصلح الإمام الحسن (عليه السّلام) معه.
وثالثة: في نهضة الإمام الحسين (عليه السّلام) التي خُتمت بفاجعة الطفّ، وأثرها في الإسلام بكيانه العام.
فهنا مقامات ثلاثة:
المقام الأوّل
في جهود أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)
وجهود الخاصّة من الصحابة
والتابعين الذين كانوا معه
أشرنا آنفاً إلى أنّ قيام السلطة بعد انحرافها عن خطّ أهل البيت بالفتوح الكبرى، وما استتبعها من الغنائم العظيمة كان هو السبب في نشر الإسلام بواقعه المنحرف.
كما إنّ له أعظم الأثر في احترام الإسلام المذكور، واحترام رموزه في نفوس عامّة المسلمين، خصوصاً بعد ما سبق من التحجير على السُنّة النبويّة، ومنع الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلّا بما يتناسب مع نهج السلطة وتوجّهاته، ولو بوضع الأحاديث، والكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصالحها.
إلاّ إنّ الانحراف لما ابتنى على عدم نظام للسلطة؛ فقد صارت السلطة معرضة لأن تكون مطمعاً لكلّ أحد من قريش قبيلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم - التي ابتنى الانحراف الفاتح على اختصاص حقّ الخلافة بها من دون فرق بين قبائلها - مهما كان حال الشخص ومقامه في الإسلام.
وقد روي عن سلمان الفارسي (رضي الله عنه) أنّه قال لما بويع أبو بكر: كرديد نكرديد. أما والله، لقد فعلتم فعلة أطمعتم فيها الطلقاء ولعناء رسول الله(١) .
____________________
١ - الإيضاح/٤٥٧ - ٤٥٨.
تخوّف عمر بن الخطاب من أطماع قريش
كما إنّ شدّة عمر بن الخطاب وضيق بعض الصحابة من ذلك - على ما سبق في حديث طلحة وغيره(١) - جعلته يخشى من محاولة قريش التخلّص منه، أو الخروج عليه حتى إنّه لما طُعن لم يبرئ الصحابة من التآمر عليه، بل سألهم فقال: عن ملأ منكم ومشورة كان هذا الذي أصابني؟ فتبرؤوا من ذلك وحلفوا(٢) .
وقد أدرك أنّ عامّة المسلمين المنتشرين في أقطار الأرض ما داموا في سكرة الفتوح والغنائم والانتصارات فهم في غفلة عن كلّ تغيير، بل هم يستنكرون ذلك لما للسلطة ورموزها من الاحترام في نفوسهم.
تحجير عمر على كبار الصحابة
ومن أجل إبقائهم على غفلتهم رأى أنّ اللازم الحجر على كبار الصحابة وذوي الشأن منهم وحبسهم في المدينة المنوّرة، وجعلهم تحت سيطرته بحيث لا يخرج منهم خارج عنها إلّا تحت رقابة مشدّدة؛ من أجل الالتزام بتعاليمه والسير على خطّه، ولا أقل من عدم الخروج عنه وزرع بذور الخلاف والانشقاق.
لأنّ صحبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقدمهم في الإسلام، واشتراكهم في حروبه الأولى تجعل لهم حرمة في نفوس عامّة المسلمين قد يستغلّونها من أجل كشف
____________________
١ - تقدّم في/١٧٥ وما بعده.
٢ - المصنّف - لعبد الرزاق ١٠/٣٥٧ كتاب أهل الكتابين، باب هل يدخل المشرك الحرم، المصنّف - لابن أبي شيبة ٨/٥٨١ - ٥٨٢ كتاب المغازي، ما جاء في خلافة عمر بن الخطاب، الاستيعاب ٣/١١٥٣ - ١١٥٤ في ترجمة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)، الطبقات الكبرى ٣/٣٤٨ ذكر استخلاف عمر (رحمه الله)، تاريخ دمشق ٤٤/٤٢٠ في ترجمة عمر بن الخطاب، تاريخ المدينة ٣/٩٠٤ دعاء عمر عند طعنه، شرح نهج البلاغة ١٢/١٨٧، وغيرها من المصادر.
الحقيقة، وإيضاح واقع الإسلام الحقّ، أو من أجل تثبيت مراكز قوّة ونفوذ لهم في مقابل السلطة؛ لتحقيق أطماعهم الشخصية، أو نحو ذلك ممّا قد يؤدّي إلى تعدّد الاتجاهات داخل الكيان الإسلامي، وظهور الخلافات أو حصول الشقاق.
وهذا بخلاف حديثي الإسلام والمنافقين على ما تقدّم توضيحه عند التعرّض للخطوات التي قامت بها السلطة من أجل تثبيت شرعيتها.
وقد تقدّم منه أنّه لما سُئل عن توليته المؤلّفة قلوبهم والطلقاء وأبناءهم، وترك أمير المؤمنين (عليه السّلام) والعباس والزبير وطلحة، قال: أمّا علي فأنبه من ذلك، وأمّا هؤلاء النفر من قريش فإنّي أخاف أن ينتشروا في البلاد، فيكثروا فيها الفساد(١) .
وعن قيس بن حازم قال: جاء الزبير إلى عمر بن الخطاب يستأذنه في الغزو، فقال عمر: اجلس في بيتك، فقد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فردّد ذلك عليه، فقال له عمر في الثالثة أو التي تليها: اقعد في بيتك. فوالله، إنّي لأجد بطرف المدينة منك ومن أصحابك أن تخرجوا فتفسدوا على أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم(٢) .
وفي رواية أخرى: فانطلق الزبير وهو يتذمّر. فقال عمر: مَنْ يعذرني من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لولا أنّي أمسك بفمٍ هذا الشغب لأهلك أُمّة محمد صلى الله عليه وآله وسلم(٣) .
وفي رواية ابن عساكر: مَنْ يعذرني من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لولا أنّي أمسك بفمي هذا الشِعب لأهدموا أُمّة محمد صلى الله عليه وآله وسلم(٤) .
____________________
١ - شرح نهج البلاغة ٩/٢٩ - ٣٠.
٢ - المستدرك على الصحيحين ٣/١٢٠ كتاب معرفة الصحابة، ومن مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ممّا لم يخرجاه، واللفظ له، عون المعبود ١١/٢٤٦ - ٢٤٧، كنز العمّال ١١/٢٦٧ ح ٣١٤٧٦.
٣ - تاريخ بغداد ٧/٤٦٤ في ترجمة الحسن بن يزيد بن ماجة بن محمد القزويني.
٤ - تاريخ دمشق ١٨/٤٠٣ في ترجمة الزبير بن العوام.
قال اليعقوبي: واستأذن قوم من قريش عمر في الخروج للجهاد، فقال: قد تقدّم لكم مع رسول الله. قال: إنّي آخذ بحلاقيم قريش على أفواه هذه الحرّة، لا تخرجوا فتسللوا بالناس يميناً وشمالاً. قال عبد الرحمن بن عوف: فقلت: نعم يا أمير المؤمنين، ولِمَ تَمنعنا من الجهاد؟ فقال: لأن أسكت عنك فلا أجيبك خير لك من أن أُجيبك. ثمّ اندفع يحدّث عن أبي بكر حتى قال: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرّها، فمَنْ عاد لمثلها فاقتلوه(١) .
وعن الشعبي أنّه قال: لم يمت عمر (رضي الله عنه) حتى ملّته قريش، وقد كان حصرهم بالمدينة فامتنع عليهم، وقال: إنّ أخوف ما أخاف على هذه الأُمّة انتشاركم في البلاد. فإن كان الرجل يستأذنه في الغزو - وهو ممّن حبس في المدينة من المهاجرين ولم يكن فعل ذلك بغيرهم من أهل مكة - فيقول: قد كان لك في غزوك مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يبلغك، وخير لك من الغزو اليوم أن لا ترى الدنيا ولا تراك، فلمّا ولي عثمان خلّى عنهم فاضطربوا في البلاد، وانقطع إليهم الناس(٢) .
قال محمد بن طلحة: فكان ذلك أوّل وهن دخل على الإسلام، وأوّل فتنة كانت في العامّة ليس إلّا ذلك(٣) .
____________________
١ - تاريخ اليعقوبي ٢/١٥٧ - ١٥٨ في أيام عمر بن الخطاب.
٢ - تاريخ الطبري ٣/٤٢٦ أحداث سنة خمس وثلاثين من الهجرة، ذكر بعض سير عثمان بن عفان (رضي الله عنه)، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٣/١٨٠ أحداث سنة خمس وثلاثين من الهجرة، ذكر بعض سيرة عثمان، تاريخ دمشق ٣٩/٣٠٢ - ٣٠٣ في ترجمة عثمان بن عفان، كنز العمّال ١٤/٧٦ ح ٣٧٩٧٨، شرح نهج البلاغة ١١/١٢ - ١٣، وغيرها من المصادر.
٣ - تاريخ الطبري ٣/٤٢٦ أحداث سنة خمس وثلاثين من الهجرة، ذكر بعض سير عثمان بن عفان (رضي الله عنه)، واللفظ له، كنز العمّال ١٤/٧٦ ح ٣٧٩٧٨، تاريخ دمشق ٣٩/٣٠٢ في ترجمة عثمان بن عفان، وغيرها من المصادر.
توقّف أهل البيت (عليهم السّلام) عن تنبيه عامّة المسلمين لحقّهم في الخلافة
ونتيجة لجميع ما سبق لا بدّ أن يتوقّف أهل البيت (صلوات الله عليهم) والخاصّة من شيعتهم عن تنبيه عامّة الناس لحقّهم (عليهم السّلام) في الخلافة، ولحصول التشويه والتحريف في كثير من الحقائق الدينية؛ لعدم حصول الأرضية المناسبة لذلك، ويقتصر نشاطهم على الخاصّة من أجل إعدادهم للعمل في الوقت المناسب.
ولاسيما أنّ أخلاقياتهم ومثلهم واهتمامهم بفرض احترامهم على المسلمين قد تمنعهم من أن يُعرف عنهم أنّهم السبب في شقّ كلمة المسلمين، وزرع بذور الخلاف والشقاق بينهم، وكانوا يرون أنّ الأنسب لهم أن تظهر أسباب الخلاف والشقاق والفتنة من غيرهم، وهو ما يتوقّع حصوله في القريب العاجل بسبب تداعيات الانحراف الذي حصل في السلطة.
إحساس عمر بأنّ الاستقرار على وشك النهاية
وكان عمر بن الخطاب قد أدرك ذلك، وعرف أنّ زمان الاستقرار على وشك النهاية. قال ابن أبي الحديد: وروى أبو جعفر الطبري في تاريخه، قال: كان عمر قد حجّر على أعلام قريش من المهاجرين الخروج في البلدان إلّا بإذن وأجل، فشَكَوه، فبلغه، فقام فخطب فقال: ألا إنّي قد سننت الإسلام سنّ البعير، يبدأ فيكون جذع، ثمّ ثني، ثمّ يكون رباعي، ثمّ سديس، ثمّ بازل. ألا فهل ينتظر بالبازل إلّا النقصان.
ألا وإنّ الإسلام قد صار بازلاً، وإنّ قريشاً يريدون أن يتّخذوا مال الله معونات على ما في أنفسهم. ألا إنّ في قريش مَنْ يضمر الفرقة، ويروم خلع الربقة. أما وابن الخطاب حيّ فلا، إنّي قائم دون شعب الحرّة، آخذ بحلاقيم
قريش وحُجَزها أن يتهافتوا في النار(١) . ولعلّ ذلك هو المنشأ لما سبق من شكّه في الصحابة، واحتماله تآمرهم عليه لما طُعن.
تنبؤ الصديقة الزهراء (عليها السّلام) باضطراب أوضاع المسلمين
وهو ما توقّعته الصديقة فاطمة الزهراء (صلوات الله عليه) للأُمّة في مبدأ انحراف مسار السلطة وخروجها عن موضعها الذي جعلها الله (عزّ وجلّ) فيه، حيث قالت (عليها السّلام) في ختام خطبتها الصغيرة:
«أما لعمري، لقد لقحت فنظرة ريثما تنتج، ثمّ احتلبوا ملأ القعب دماً عبيطاً، وزعافاً مبيداً. هنالك( يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ ) ، ويعرف البطالون غبّ ما أسس الأوّلون، ثمّ طيبوا عن دنياكم أنفساً، واطمئنوا للفتنة جأشاً، وابشروا بسيف صارم، وسطوة معتدٍ غاشم، وبهرج شامل، واستبداد من الظالمين يدع فيئكم زهيداً، وجمعكم حصيداً...»(٢) .
مجمل الأوضاع في أوائل عهد عثمان
وأخيراً انتهى عهد عمر وجاء عهد عثمان، وعامّة المسلمين بعد في غفلتهم، قد غلبت عليهم سكرة الفتوح والغنائم، وتوسّع رقعة الإسلام، ودخول الناس فيه أفواجاً، وما استتبع ذلك من تمجيد الحكّام الذين حصلت الفتوح على عهدهم، وظهرت الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والألقاب
____________________
١ - شرح نهج البلاغة ١١/١٢، وقريب منه في تاريخ الطبري ٣/٤٢٦ أحداث سنة خمس وثلاثين من الهجرة، ذكر بعض سير عثمان بن عفان (رضي الله عنه)، وتاريخ دمشق ٣٩/٣٠٢ في ترجمة عثمان بن عفان، وكنز العمّال ١٤/٧٥ ح ٣٧٩٧٧، وغيرها من المصادر إلّا أنّه قد حُذفت منها: إنّ في قريش مَنْ يضمر الفرقة، ويروم خلع الربقة.
٢ - راجع ملحق رقم ٢.
المنتحلة التي ترفع من شأنهم، على ما سبق.
غفلة العامّة عن ابتناء بيعة عثمان على الانحراف
وقد أذهلهم ذلك كلّه عن تمادي السلطة في الانحراف عن الخطّ السليم في الإسلام؛ نتيجة المخالفات الكثيرة، ومنها ما تمّت على أساسه بيعة عثمان، وهو أخذ سيرة أبي بكر وعمر شرطاً في البيعة يُضاف إلى موافقة كتاب الله (عزّ وجلّ) وسُنّة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلها في مرتبة واحدة؛ من أجل إقصاء أمير المؤمنين (عليه السّلام) الذي يعلم الخاصّة الذين بيدهم الحلّ والعقد ومَنْ سار في خطّهم أنّه كما قال له عمر: أما والله، لئن وليتهم لتحملنّهم على الحقّ الواضح والمحجّة البيضاء(١) ، وكما قال عنه لابن عباس: ولئن وليهم ليأخذنّهم بمرّ الحقّ لا يجدون عنده رخصة...(٢) . وفي حديث عبد الرحمن بن عبد القاري في حوار بين عمر وبين رجل من الأنصار: ثمّ قال عمر للأنصاري: مَنْ ترى الناس يقولون يكون الخليفة بعدي؟ قال: فعدّد رجالاً من المهاجرين، ولم يسمِّ عليّاً. فقال عمر: فما لهم من أبي الحسن؟ فوالله إنّه لأحراهم إن كان عليهم أن يقيمهم على طريقة من الحقّ(٣) .
____________________
١ - شرح نهج البلاغة ١/١٨٦، واللفظ له، ويوجد هذا المعنى بألفاظ مختلفة في شرح نهج البلاغة ٦/٣٢٧، و١٢/٥٢، ٢٥٩ - ٢٦٠، والمستدرك على الصحيحين ٣/٩٥ كتاب معرفة الصحابة، ومن مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)، والاستيعاب ٣/١١٣٠ في ترجمة علي بن أبي طالب، والمصنّف - لعبد الرزاق ٥/٤٤٦ - ٤٤٧ كتاب المغازي، بيعة أبي بكر (رضي الله عنه) في سقيفة بني ساعدة، والطبقات الكبرى ٣/٣٤٢ في ترجمة عمر، ذكر استخلاف عمر (رحمه الله)، والأدب المفرد/١٢٨ البغي، وكنز العمّال ٥/٧٣٤ ح ١٤٢٥٤، وص ٧٣٦ ح ١٤٢٥٨، وص ٧٣٦ - ٧٣٧ ح ١٣٢٦٠، وغيرها من المصادر الكثيرة.
٢ - تاريخ اليعقوبي ٢/١٥٩ أيام عمر بن الخطاب.
٣ - المصنّف - لعبد الرزاق ٥/٤٤٦ كتاب المغازي، بيعة أبي بكر (رضي الله تعالى عنه) في سقيفة بني ساعدة، واللفظ له، الأدب المفرد - للبخاري/١٢٨ البغي، كنز العمّال ٥/٧٣٦ - ٧٣٧ ح ١٤٢٦٠، وغيرها من المصادر، وقريب منه في أنساب الأشراف ٣/١٤ - ١٥ بيعة علي بن أبي طالب (عليه السّلام).
وفي حديث عمر بن ميمون الأودي قال: كنت عند عمر بن الخطاب حين وليَ الستة الأمر، فلمّا جازوا أتبعهم بصره، ثمّ قال: لئن ولّوها الأجيلح ليركبن بهم الطريق، يريد عليّاً(١) .
وفي حديث أبي مجلز في مثل ذلك: قال عمر: مَنْ تستخلفون بعدي؟... فقال رجل من القوم: نستخلف عليّاً. فقال: إنّكم لعمري لا تستخلفونه. والذي نفسي بيده لو استخلفتموه لأقامكم على الحقّ وإن كرهتم...(٢) .
كما يعلمون أنّه (عليه السّلام) لو وليَ الخلافة لوسعه أن يظهر الحقيقة، ثمّ لم تخرج الخلافة عن أهل البيت (صلوات الله عليهم).
وإذا كان مقام أمير المؤمنين (عليه السّلام) مجهولاً عند عامّة المسلمين نتيجة ما سبق، فالمفترض أن لا يخفى عليهم مقام الكتاب المجيد والسُنّة الشريفة، وانحصار المرجعية في العلم والعمل بهما، لولا الذهول والاندفاع في تمجيد الحكّام والتبعية لهم في الدين، الأمر الذي سبق الكلام فيه في المبحث الأوّل.
واكتفى أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) بالامتناع عن قبول الشرط المذكور - وإن أدّى ذلك إلى إقصائه عن الخلافة - التزاماً منه بمبادئه، وإقامة للحجّة على عدم شرعية هذا الشرط.
ولم يكن في وسعه (عليه السّلام) حينئذ أن يشنّع على ذلك الشرط، ويحمل العامّة
____________________
١ - المصنّف - لعبد الرزاق ٥/٤٤٦ - ٤٤٧ كتاب المغازي، بيعة أبي بكر (رضي الله تعالى عنه) في سقيفة بني ساعدة، واللفظ له، أنساب الأشراف ٢/٣٥٣ وأما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السّلام)، تاريخ دمشق ٤٢/٤٢٧ - ٤٢٨ في ترجمة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، الكامل في التاريخ ٣/٣٩٩ أحداث سنة أربعين من الهجرة، ذكر بعض سيرته (أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السّلام»، شرح نهج البلاغة ١٢/١٠٨، وغيرها من المصادر.
٢ - كنز العمّال ٥/٧٣٥ - ٧٣٦ ح ١٤٢٥٨.
على الإنكار والتغيير؛ لعدم وجود الأرضية الصالحة لذلك، بعدما سبق من اندفاع الناس مع أولياء الأمور، مع إنّه ربما كان لا يرى الصلاح في أن يبدأ هو بشقّ كلمة المسلمين، وزرع بذور الخلاف بينهم على ما أشرنا إليه آنفاً.
مدى اندفاع العامّة مع السلطة في تلك الفترة
ويمكن أن نعرف مدى اندفاع الناس مع أولياء الأمور في ذلك الوقت، وعدم اهتمامهم بمعرفة الحقيقة والدفاع عنها، ممّا تقدّم في قصّة صبيغ بن عسل(١) من امتناع الناس عن مجالسته لمنع عمر عن ذلك من دون أن يذكروا جرمه أو يقيموه.
وما رواه جندب بن عبد الله الأزدي عند تعرّضه للمشادّة بين المقداد وعبد الرحمن بن عوف من أجل إقصاء أمير المؤمنين (عليه السّلام) في تلك الشورى، وما تقدّم من قول المقداد: أما والله، لو أنّ لي على قريش أعواناً لقاتلتهم قتالي إيّاهم ببدر وأُحد(٢) .
قال جندب: فأتبعته، وقلت له: يا عبد الله، أنا من أعوانك. فقال: رحمك الله، إنّ هذا الأمر لا يغني فيه الرجلان ولا الثلاثة.
قال: فدخلت من فوري ذلك على علي (عليه السّلام) فقلت: يا أبا الحسن، والله ما أصاب قومك بصرف هذا الأمر عنك. فقال: «صبر جميل، والله المستعان». فقلت: والله إنّك لصبور. قال: «فإن لم أصبر فماذا أصنع؟»... فقلت: تقوم في الناس فتدعوهم إلى نفسك، وتخبرهم أنّك أولى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتسألهم النصر على هؤلاء المظاهرين عليك، فإن أجابك عشرة من مئة شددت بهم على الباقين.
____________________
١ - تقدّم في ص: ١٧٧.
٢ - تقدّم في ص: ١٩٣.
فإن دانوا لك فذاك، وإلاّ قاتلتهم وكنت أولى بالعذر قُتلت أو بقيت، وكنت أعلى عند الله حجّة.
فقال: «أترجو يا جندب أن يبايعني من كلّ عشرة واحداً؟». قلت: أرجو ذلك. قال: «لكنّي لا أرجو ذلك. لا والله، ولا من المئة واحداً...».
هذا في المدينة المنوّرة التي هي موطن المهاجرين والأنصار، والتي يعرف الكثير من أهلها أو جميعهم مقام أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) وحقّه، وما حصل من الظلم عليه خاصة وعلى أهل البيت عموماً نتيجة الانحراف.
أمّا في غيرها من أمصار المسلمين فمن الطبيعي أن يكون الحال أشدّ، والناس أبعد عن معرفة الحقيقة والاهتمام بأمره.
قال جندب بعد أن ذكر حديث أمير المؤمنين (عليه السّلام) السابق حول موقف الناس معه: فقلت: جُعلت فداك يابن عمّ رسول الله! لقد صدعت قلبي بهذا القول، أفلا أرجع إلى المصر فأوذن الناس بمقالتك، وأدعو الناس إليك؟ فقال: «يا جندب، ليس هذا زمان ذاك». قال: فانصرفت إلى العراق، فكنت أذكر فضل علي على الناس فلا أعدم رجلاً يقول لي ما أكره، وأحسن ما أسمعه قول مَنْ يقول: دع عنك هذا، وخذ فيما ينفعك، فأقول: إنّ هذا ممّا ينفعني، فيقوم عنّي ويدعني(١) .
وعن أبي الطفيل قال: خرجت أنا وعمرو بن صليع المحاربي حتى دخلنا على حذيفة... فقال: حدّثنا يا حذيفة. فقال: عمّا أحدّثكم؟ فقال: لو أنّي أحدّثكم بكلّ ما أعلم قتلتموني، أو قال: لم تصدّقوني. قالوا: وحقّ ذلك؟ قال: نعم. قالوا: فلا حاجة لنا في حقّ تحدّثناه فنقتلك عليه، ولكن حدّثنا بما ينفعنا ولا يضرّك. فقال: أرأيتم لو حدّثتكم أن أُمّكم تغزوكم إذاً صدّقتموني؟
____________________
١ - شرح نهج البلاغة ٩/٥٨.
قالوا: وحقّ ذلك؟!(١) . وقريب منه حديث خيثمة بن عبد الرحمن عن حذيفة(٢) .
وهي تدل على أنّ عامّة المسلمين قد تمسّكوا بثقافة خاصّة لا يقبلون بغيرها حتى إنّ حذيفة - مع ما له من مقام رفيع - لو حدّثهم بخلافها لكذّبوه، بل قد يقتلونه.
اختلاف عثمان عن عمر في الحزم والسلوك
ولكنّ تداعيات الانحراف في أمر السلطة بدأت تظهر للناس؛ لأنّ عثمان يختلف عن عمر بأمرين:
الأوّل : ضعف الإدارة وفقد الحزم، وسوء التعامل مع الأحداث.
الثاني : إنّه توسّع في إنفاق المال، وظهرت عليه وعلى زمرته مظاهر التسامح والترف، وقرّب بني أُميّة ومكّنهم في البلاد، وولاّهم الأمصار مع ما عرف عنهم من العداء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللإسلام، والكيد لهما في بدء الدعوة، ثمّ النفاق بعد أن اضطروا للدخول في الإسلام، ولم يمنعه ذلك من تقريبهم وتحكيمهم فاتّخذوا مال الله دولاً وعباده خولاً، وانتهكوا حرماتهم وحرمات دينهم بتخالع واستهتار بنحو لم يعهده عامّة المسلمين من قبل.
ظهور الإنكار على عثمان من عامّة المسلمين
وقد أضرّ ذلك بمصالح الخاصّة والعامّة؛ فأثار حفيظتهم كما أثار حفيظة أهل الدين، وكلّ مَنْ يهمّه الصالح العام.
____________________
١ - المصنّف - لعبد الرزاق ١١/٥٢ - ٥٣ باب القبائل.
٢ - المستدرك على الصحيحين ٤/٤٧١ كتاب الفتن والملاحم، وقال بعد إيراد الحديث: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وبذلك بدأ الإنكار على عثمان والتشنيع عليه، وإثارة مشاعر الناس ضدّه، وتهييج الرأي العام عليه، وظهرت بوادر التغيير.
تحقّق الجو المناسب لإظهار مقام أمير المؤمنين (عليه السّلام) وبيان ظلامته
وحينئذ تحقّقت الأرضية الصالحة لتعريف العامّة بمقام الإمام أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) ونشر فضائله، وهو الذي كان في الشورى الطرف الوحيد المقابل لعثمان، والذي أقصته المصالح الضيّقة، وقدّمت عليه عثمان؛ تجاهلاً لمصلحة الإسلام العلي، وتجاوزاً عليه.
وهو (عليه السّلام) يحظى بأعظم رصيد من الفضائل والمناقب، وبالمؤهّلات المميّزة في قيادة الأُمّة، والسير بها على الطريق الواضح والصراط المستقيم.
ولاسيما أنّ خاصّة شيعته المتفانين في الدعوة له قد كانت لهم المكانة السامية من بين الصحابة والتابعين بحيث يسمع منهم جمهور المسلمين، ويتفاعل بتوجيهاتهم وإرشاداتهم في خضمّ الهيجان والصراع.
جهود الخاصة في التعريف بمقامه (عليه السّلام) وكشف الحقيقة
وهنا جاء دورهم ليقوموا بمهمّتهم الكبرى التي أعدّوا لها، وذلك ببيان الحقيقة والدعوة له من أجل أن يكون التغيير المتوقّع لصالحه، لا للأسوأ، أو من أجل إقامة الحجّة على الناس لو لم يتقبّلوه، ويؤدّوا وظيفتهم إزاءها.
ولا يتيسّر لنا فعلاً الاطّلاع الكافي على مفردات ما حصل، إلّا إنّ خير شاهد على ما ذكرنا هو هتاف الجماهير باسم أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في أواخر أيّام عثمان عند ظهور النقمة عليه مع إنّه (عليه السّلام) كان أخفّ النفر على عثمان.
نعم، من المظنون قويّاً أنّ الأمر مع عامّة الناس لم يكن يتجاوز بيان الفضائل
التي تقتضي تقديمه على غيره من الموجودين، بل ربما على جميع المسلمين حتى على الشيخين، لكن من دون تركيز على النصّ القاضي باختصاص الحقّ به وبذرّيته، وعدم شرعية خلافة مَنْ سبق كما هو مذهب أهل البيت (صلوات الله عليهم)؛ لعدم تهيؤ عامّة المسلمين نفسيّاً لذلك، وعدم تقبّلهم له.
ولاسيما أنّ سيرة عثمان، وتدهور الأوضاع في عهده، وظهور الخلاف والشقاق في الكيان الإسلامي بعد استقراره، قد أكّدت في نفوسهم ما سبق من احترام الشيخين أو تقديسهم؛ نتيجة انتشار الإسلام في عهدهم، وما استتبعه من الغنائم التي لم تكن العرب تحلم بها، وألقاب التمجيد والأحاديث التي وضعت في تلك الفترة كما سبق.
مضافاً إلى أنّ في المعارضة لعثمان عناصر مهمّة هي على خلاف خطّ أهل البيت، والاعتراف بالنصّ يفوّت عليها أطماعها، كما أنّها تهتم بالتركيز على سيرة الشيخين وتمجيدهم؛ من أجل التنفير من عثمان والتهريج عليه.
وإذا كان النصّ قد ذكر وركّز عليه فمن الغريب أن يكون ذلك مقتصراً على القليل من ذوي التعقّل والدين، ممّن يهمّه معرفة الحقيقة والوصول إليها.
وعلى كلّ حال فقد أدّت الخاصة من شيعة أهل البيت (صلوات الله عليهم) - فيما يظهر - دورها الذي أعدّت له، وحقّقت خدمة كبرى للحقيقة المضطهدة التي عُتّم عليها في الفترة السابقة.
وبالمناسبة يقول ابن قتيبة عند عرض أحداث واقعة الجمل: فلمّا قدم علي طيء أقبل شيخ من طيء قد هرم من الكبر، فرفع له من حاجبيه فنظر إلى علي، فقال له: أنت ابن أبي طالب؟ قال: «نعم».
قال: مرحباً وأهلاً... لو أتيتنا غير مبايعين لك لنصرناك؛ لقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأيّامك الصالحة، ولئن كان ما يُقال فيك من الخير حقّاً إنّ في
أمرك وأمر قريش لعجب؛ إذ أخرجوك وقدّموا غيرك...(١) .
وبذلك ظهرت ثمرة الصبر والموادعة من أجل الحفاظ على هذه الثلّة الصالحة، وعدم التفريط بها في مبدأ الانحراف في السلطة عند ارتحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرفيق الأعلى.
توجّهات المعارضة لعثمان
هذا ويبدو أنّ المعارضين لعثمان على قسمين:
الأوّل : النفعيون والانتهازيون الذين يريدون القضاء على عثمان؛ لتضرّر مصالحهم، أو بأمل الحصول على مكاسب مادية، أو تبوّء مراكز قيادية من دون رؤية واضحة للنتائج المترتّبة على ذلك، أو لعدم الاهتمام بها من أجل أهدافهم.
وقد كشفتهم الأحداث بعد مقتل عثمان، والتداعيات التي ترتّبت عليه، ممّا يسهّل التعرّف عليه بالرجوع لتاريخ تلك الفترة.
الثاني : الناقمون من سوء الأوضاع الذين يريدون تحسّنها، وتحقيق السلطة للعدالة والتزامها بها من دون أن يكون لهم مشروع خاصّ لحلّ المشكلة، وهم الأكثرية.
مقتل عثمان بعد فشل مساعي أمير المؤمنين (عليه السّلام) لحلّ الأزمة
أمّا أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) فقد بذل جهده من أجل إصلاح الأمور، وحلّ المشكلة بين عثمان والناس؛ تجنّباً للفتنة حيث يعلم (عليه السّلام) بما يترتّب عليها من تداعيات وسلبيات على الإسلام والمسلمين.
ويشير إلى ذلك كلامه (عليه السّلام) مع عثمان حينما دخل عليه بعد أن شكاه الناس
____________________
١ - الإمامة والسياسة ١/٥٢ استنفار عدي بن حاتم قومه لنصرة علي (رضي الله عنه).
له، حيث قال في جملته: «وإنّي أنشدك الله أن لا تكون إمام هذه الأُمّة المقتول؛ فإنّه كان يُقال: يُقتل في هذه الأُمّة إمام يفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة، ويلبس أمورها عليها، ويبثّ الفتن عليها، فلا يبصرون الحقّ من الباطل، يموجون فيها موجاً، ويمرجون فيها مرجاً»(١) .
وقد كاد أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسّلام) يستوعب الخلاف، ويحلّ الأزمة بسلام، لولا سوء إدارة عثمان، وفساد بطانته، وضعف شخصيته، وتأرجح موقفه.
وانتهى الأمر بحصار عثمان ثمّ قتله، بل المنع من دفنه لولا استنجاد ذويه بأمير المؤمنين (عليه السّلام)(٢) .
مطالبة الجماهير ببيعة أمير المؤمنين (عليه السّلام)
واندفعت بعد ذلك الجماهير من خاصة المسلمين وعامّتهم تريد بيعة أمير المؤمنين (عليه السّلام)؛ لأنّه الشخصية الأولى - ولو في عصره - بنظرهم، ولما يتميّز به من مؤهّلات - وعمدتها عندهم العلم، والاستقامة، والسابقة، والأثر الحميد في الإسلام، والقرابة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمل تحقّق الإصلاح على يديه، وسير عجلة الإسلام في الطريق الصحيح وفي مأمن من الاستئثار والفساد.
____________________
١ - نهج البلاغة ٢/٦٩، واللفظ له، تاريخ الطبري ٣/٣٧٦ أحداث سنة أربع وثلاثين من الهجرة، ذكر الخبر عن صفة اجتماعهم لذلك وخبر الجرعة، الكامل في التاريخ ٣/١٥١ أحداث سنة أربع وثلاثين من الهجرة، ذكر ابتداء قتل عثمان، البداية والنهاية ٧/١٨٨ - ١٨٩ أحداث سنة أربع وثلاثين من الهجرة، إمتاع الأسماع ١٣/٢٠٨، وغيرها من المصادر.
٢ - شرح نهج البلاغة ٢/١٥٨، و١٠/٦، تاريخ الطبري ٣/٤٣٨ أحداث سنة خمس وثلاثين من الهجرة، ذكر الخبر عن الموضع الذي دفن فيه عثمان (رضي الله عنه)، الكامل في التاريخ ٣/١٨٠ أحداث سنة خمس وثلاثين من الهجرة، ذكر الموضع الذي دُفن فيه ومَنْ صلّى عليه، وغيرها من المصادر.
وربما كان هدف كثير ممّن يعرف حق أهل البيت (صلوات الله عليهم) تعديل مسار السلطة في الإسلام بذلك، ورجوع الحقّ إلى أهله في مأمن من الزيغ والانحراف.
إباء أمير المؤمنين (عليه السّلام) البيعة تنبئه بالمستقبل القاتم
وكيف كان فقد امتنع (صلوات الله عليه) من القبول بالبيعة؛ لعلمه بأنّه لا يتم لهم ما أرادوا؛ لأنّ الناس - ولاسيما الخاصة - لا تطيق عدله، والتزامه بنصوص الدين بعد أن تعودّت على التسامح، وفتحت عيونها على الدنيا، وراقهم زبرجها.
وكان فيما قال إيضاحاً للحال، وكبحاً لجماح التفاؤل والآمال: «دعوني والتمسوا غيري؛ فإنّا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان، لا تقوم به القلوب، ولا تثبت عليه العقول»(١) . وقد أشار (عليه أفضل الصلاة والسّلام) إلى ما توقّعته الصديقة فاطمة الزهراء (صلوات الله عليه) في كلامها السابق، وهما يأخذان من أصل واحد.
ولمّا أصرّوا عليه قال (عليه السّلام) إقامة للحجّة: «قد أجبتكم، واعلموا أنّي إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، وإن تركتموني فإنّما أنا كأحدكم، إلّا أنّي أسمعكم وأطوعكم لِمَنْ ولّيتموه»(٢) .
____________________
١ - نهج البلاغة ١/١٨١، واللفظ له، تاريخ الطبري ٣/٤٥٦ أحداث سنة خمس وثلاثين من الهجرة، خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، الكامل في التاريخ ٣/١٩٣ أحداث سنة خمس وثلاثين من الهجرة، ذكر بيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، الفتوح - لابن أعثم ٢/٤٣١ ذكر بيعة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، وغيرها من المصادر.
٢ - الكامل في التاريخ ٣/١٩٣ أحداث سنة خمس وثلاثين من الهجرة، ذكر بيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، واللفظ له، تاريخ الطبري ٣/٤٥٦ أحداث سنة خمس وثلاثين من الهجرة، خلافة أمير =
بيعة أمير المؤمنين (عليه السّلام) وما استتبعها من تداعيات
وأخيراً تمّت البيعة، وتوالت الفتن والأحداث على النحو المعلوم تاريخياً، وكان آخرها مقتل أمير المؤمنين، وصلح الإمام الحسن (صلوات الله عليهما)، واستيلاء معاوية على السلطة، والقضاء على مشروع الإصلاح، حيث لم يُكتب له الاستمرار ست سنين، رغم الجهود الجبّارة والتضحيات الكبرى من أجل المحافظة عليه وتنفيذه.
قد يبدو فشل أمير المؤمنين (عليه السّلام) في تسلّمه للسلطة
وبذلك يبدو لأوّل وهلة فشل أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في تسلّمه السلطة، وأنّه لم يحقّق نجاحاً، بل زادت الأمور سوءاً؛ لأنّه (عليه السّلام) اضطر لمباشرة حروب ثلاثة ذهب ضحيّتها كثير من المسلمين، وزادت بسببها مشاكلهم وخلافاتهم، ثمّ تسنّم السلطة معاوية ومَنْ بعده من الأمويين وغيرهم، وكانت عهودهم أسوأ بكثير بحسب المنظور العام من عهد عثمان ومَنْ قبله.
علمه (عليه السّلام) بفشل مشروع الإصلاح الجذري
لكنّ أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) كان يعلم من أوّل الأمر بفشل مشروع الإصلاح الذي طلبوا منه البيعة من أجله، كما يشير إلى ذلك ما تقدّم من قوله (عليه السّلام): «فإنّا مستقبلون أمراً له وجوه وله ألوان، لا تقوم به القلوب، ولا تثبت عليه العقول»، وما يأتي من خطبته حين بويع.
وقد عهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم - بل للأُمّة عامّة - بخروج الناكثين والقاسطين والمارقين عليه(١) ، وبكثير من تفاصيل ذلك، ومنها إرغامه على
____________________
= المؤمنين علي بن أبي طالب، نهج البلاغة ١/١٨٢، وغيرها من المصادر.
١ - المستدرك على الصحيحين ٣/١٣٩،١٤٠ كتاب معرفة الصحابة، فضائل علي بن أبي طالب (رضي الله عنه): =
التحكيم(١) ، وما استتبعه من فتنة الخوارج(٢) ، ثمّ قتله (عليه السّلام) بعد أن يتجرّع الغيظ(٣) ، وبقيام دولة بني أُميّة الشجرة الملعونة في القرآن(٤) .
____________________
= إخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل علي، مجمع الزوائد ٥/١٨٦ كتاب الخلافة، باب الخلفاء الأربعة، و٦/٢٣٥ كتاب قتال أهل البغي، باب ما جاء في ذي الثدية وأهل النهروان، و٧/٢٣٨ كتاب الفتن، باب فيما كان بينهم في صفين، السُنّة - لعمرو بن أبي عاصم/٤٢٥، مسند أبي يعلى ١/٣٩٧ مسند علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه)، و٣/١٩٤ - ١٩٥ مسند عمار بن ياسر، المعجم الكبير ٤/١٧٢ فيما رواه محنف بن سليم عن أبي أيوب، و١٠/٩١ - ٩٢ باب من روى عن ابن مسعود، المعجم الأوسط ٨/٢١٣، و٩/١٦٥، الاستيعاب ٣/١١١٧ في ترجمة علي بن أبي طالب، وغيرها من المصادر الكثيرة.
١ - السنن الكبرى - للنسائي ٥/١٦٧ كتاب الخصائص، ذكر خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، ذكر ما خصّ به علي من قتال المارقين، ذكر الأخبار المؤيدة لما تقدّم وصفه، فتح الباري ٧/٣٨٦، شرح نهج البلاغة ٢/٢٣٢، تاريخ الإسلام ٢/٣٩١ قصّة غزوة الحديبية، السيرة الحلبية ٢/٧٠٧ غزوة الحديبية، مجمع البيان - للطبرسي ٩/١٩٩، وغيرها من المصادر.
٢ - مجمع الزوائد ٦/٢٤١ كتاب قتال أهل البغي، باب منه في الخوارج، فتح الباري ١٢/٢٦٤ - ٢٦٥، مسند أبي يعلى ١/٣٧٠ - ٣٧١ مسند علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، المصنّف - لعبد الرزاق ٣/٣٥٨ كتاب فضائل القرآن، باب سجود الرجل شكر، السُنّة - لعمرو بن أبي عاصم/٥٨٥، السنن الكبرى ٥/١٦٣ كتاب الخصائص، ثواب من قاتلهم (الخوارج)، المعجم الأوسط ٤/٢٢٤، تاريخ بغداد ١٢/٤٤٨ في ترجمة قيس بن أبي حازم، و١٣/٩٧ في ترجمة مسلم بن أبي مسلم، وص ٢٢٣ في ترجمة ميسرة أبي صالح، كنز العمّال ١١/٢٨٩ - ٢٩٠ ح ٣١٥٤٨، وغيرها من المصادر الكثيرة.
٣ - المستدرك على الصحيحين ٣/١٣٩ كتاب معرفة الصحابة، ومن مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ممّا لم يخرجاه، ذكر إسلام أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه)، تاريخ دمشق ٤٢/٤٢٢، ٥٣٦ في ترجمة علي بن أبي طالب، الكامل في التاريخ ٣/٣٨٨ أحداث سنة أربعن من الهجرة، ذكر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السّلام)، ذكر أخبار أصبهان ٢/١٤٧ في ترجمة عطاء بن السائب، كنز العمّال ١١/٦١٨ ح ٣٢٩٩٩، الفصول المهمّة ١/٦٠٩ الفصل الأوّل في ذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (كرّم الله وجهه)، فصل في مقتله ومدّة عمره وخلافته (عليه السّلام)، وغيرها من المصادر.
٤ - سنن الترمذي ٥/١١٥ كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، باب سورة القدر، المستدرك على الصحيحين ٣/١٧٠ - ١٧١ كتاب معرفة الصحابة، ومن فضائل الحسن بن علي بن أبي طالب (رضي الله عنهم) وذكر مولده ومقتله، سير أعلام النبلاء ٣/٢٧٢ في ترجمة الحسن بن علي بن أبي طالب. =
وهو القائل: «أتاني عبد الله بن سلام، وقد وضعت رجلي في الغرز، وأنا أريد العراق، فقال: لا تأتي [كذا في المصدر] العراق؛ فإنّك إن أتيته أصابك به ذباب السيف». قال أبو الأسود الدؤلي: قال علي: «وأيم الله، لقد قالها لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبلك»(١) .
والقائل في حرب صفين، وهو في أوج قوّته العسكرية: «ما اختلفت أُمّة قطّ بعد نبيّها إلّا ظهر أهل باطلها على أهل حقّها»(٢) ، والقائل في الكوفة: «إنّي أُقاتل على حقّ؛ ليقوم، ولن يقوم، والأمر لهم»(٣) .
كما قال (عليه السّلام) أيضاً: «أما إنّه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم، مندحق البطن، يأكل ما يجد، ويطلب ما لا يجد فاقتلوه، ولن تقتلوه، ألا وإنّه سيأمركم بسبّي والبراءة منّي...»(٤) ، إلى غير ذلك ممّا يجده الناظر في تاريخ تلك الحقبة وما يتعلّق بها، ولاسيما ما ورد في أخبار أهل البيت (صلوات الله عليهم).
____________________
= المعجم الكبير ٣/٨٩ - ٩٠ فيما رواه يوسف بن مازن الراسبي عن الحسن بن علي (رضي الله عنه)، مسند الشاميين ٢/١٥٢، فضائل الأوقات - للبيهقي/٢١١ باب فضل ليلة القدر، تاريخ دمشق ١٣/٢٧٨ - ٢٧٩ في ترجمة الحسن بن علي بن أبي طالب، أُسد الغابة ٢/١٤ في ترجمة الحسن بن علي بن أبي طالب، وغيرها من المصادر الكثيرة.
١ - المستدرك على الصحيحين ٣/١٤٠ كتاب معرفة الصحابة، ومن مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ممّا لم يخرجاه، ذكر إسلام أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه)، واللفظ له، صحيح ابن حبان ١٥/١٢٧ باب إخباره صلى الله عليه وآله وسلم عمّا يكون في أُمّته من الفتن والحوادث، ذكر الإخبار عن خروج علي بن أبي طالب (رضوان الله عليه) إلى العراق، مسند الحميدي ١/٣٠، الآحاد والمثاني ١/١٤٤، موارد الظمآن ٧/١٤٨، تاريخ دمشق ٤٢/٥٤٥ في ترجمة علي بن أبي طالب، أُسد الغابة ٤/٣٤ في ترجمة علي بن أبي طالب، وغيرها من المصادر الكثيرة.
٢ - وقعة صفين/٢٢٤، شرح نهج البلاغة ٥/١٨١، الأمالي - للمفيد/٢٣٥، الأمالي - للطوسي/١١.
٣ - الفتن - لابن حماد/٧٠ ما يذكر في ملك بني أُميّة وتسمية أسمائهم بعد عمر (رضي الله عنه)، واللفظ له، إمتاع الأسماع ١٢/٢١١ إخباره صلى الله عليه وآله وسلم بملك معاوية، الملاحم والفتن - لابن طاووس/٣٣٩ ب ٣٧.
٤ - نهج البلاغة ١/١٠٥ - ١٠٦.
أهداف أمير المؤمنين (عليه السّلام) من تسلّمه للسلطة
ومن هنا لا بدّ أن يكون هدفه (صلوات الله عليه) من تسنّم السلطة ليس هو ما اندفعت الجماهير له وتخيّلته ممكن من إصلاح الأوضاع العامّة، أو تعديل مسار السلطة في الإسلام، وإنّما الدافع المهم له عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بالقيام بالأمر إذا وجد أنصاراً حيث يأتي منه (عليه السّلام) التصريح حين بويع بأنّه قد نُبئ بهذا المقام وهذا اليوم.
وهو (عليه السّلام) القائل في الخطبة الشقشقية: «أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لولا حضور الحاضر، وقيام الحجّة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء أن لا يقارّوا على كظّة ظالم ولا سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها، ولسقيت آخرها بكأس أوّلها، ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عَنز»(١) ... إلى غير ذلك ممّا يشهد بأنّه (عليه السّلام) ينفذ عهداً عُهِد له وأمراً فرض عليه، وربما يأتي بعض كلامه (عليه السّلام) في ذلك.
وعلم الله تعالى ما هي المصالح والأهداف التي ألزمته (عليه السّلام) بذلك، لكنّ الذي يظهر لنا أمران مهمّان جدّاً في صالح الإسلام بعد تحقّق الانحراف في مسيرته، وفرضه عليه كواقع لا يمكن التخلّص منه.
سعيه (عليه السّلام) لإيضاح الحقائق الدينية
الأمر الأوّل : ما أشرنا إليه آنفاً من أنّ جمهور المسلمين كانوا في غفلة عن انحراف مسار السلطة في الإسلام، وتحكّمها في الدين بحيث كان معرضاً للضياع والتشويه، فإبقاؤهم على غفلتهم يضيّع عليهم معالم الحقّ، ويعرّض
____________________
١ - نهج البلاغة ١/٣٦ - ٣٧، واللفظ له، علل الشرائع ١/١٥١، الإفصاح - للمفيد/٤٦، ينابيع المودّة ١/٤٣٨، وغيرها من المصادر.
الدين للتحريف التدريجي بتعاقب السلطات غير المشروعة حتى يُمسخ كما مُسخت بقيّة الأديان؛ نتيجة تحكّم غير المعصوم فيه.
فكان الهدف من تسنمه (صلوات الله عليه) للسلطة أن يُفسح المجال له ولمَنْ يعرف حقّه من الصحابة لكشف حقيقة الحال، وتنبيه الأُمّة من غفلتها، وتعريفها بدعوة الحقّ، وإيضاح معالمه؛ ليحملها - بل قد يدعو لها - مَنْ يوفّقه الله تعالى لذلك.
وذلك من أجل أن تظهر هذه الدعوة الشريفة في المجتمع الإسلامي والإنساني على الصعيد العام بحيث يسمع صوته؛ لتقوم الحجّة على الناس حتى لو عاد مسار السلطة للانحراف كما هو المتوقّع له (عليه السّلام) والذي حصل فعلاً.
وقد يشير إلى ذلك ما ورد عنه (صلوات الله عليه) في بيان ما دعاه لقبول الخلافة من قوله: «والله، ما تقدّمت عليها إلّا خوفاً من أن ينزو على الأمر تيس من بني أُميّة فيلعب بكتاب الله عزّ وجلّ»(١) .
إصحاره (عليه السّلام) بالحقيقة وبحقّه في الخلافة وبظلامته
وعلى كلّ حال فقد تحقّق له ذلك؛ حيث وجد الأرضية الصالحة، خصوصاً في الكوفة، فأصحر (عليه السّلام) هو ومَنْ يعرف حقّه من الصحابة بالحقيقة، وبمقامه ومقام أهل البيت (صلوات الله عليهم)، والتأكيد على استحقاقهم الخلافة، واختصاص الإمامة الحقّة بهم، وأنّهم (عليهم السّلام) المرجع للأُمّة في دينها يعصمونها من الزيغ والضلال مع الاستدلال على ذلك بالكتاب المجيد، والنصوص النبويّة الشريفة التي هي أكثر من أن تُحصى.
____________________
١ - أنساب الأشراف ٢/٣٥٣ في ترجمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السّلام)، ونحوه في بحار الأنوار ٣٤/٣٥٨.
ثمّ أصحر بالشكوى من الانحراف الذي حصل، وسلْب الشرعية عنه، وشجْب مَنْ قام به وغير ذلك ممّا سجّله التاريخ واستوعبته كتب الكلام، واشتمل على كثير منه كتاب نهج البلاغة.
إيضاحه للمراد من الجماعة التي يجب لزومها
كما إنّه (عليه أفضل الصلاة والسّلام) أوضح أنّ المراد بالجماعة التي لا يجوز الخروج عنها هي جماعة الحقّ التي تُعتصم بأئمّة الحقّ (صلوات الله عليهم)، وهو (عليه السّلام) أوّلهم.
ففي حديث عبد الله بن الحسن قال: كان علي يخطب، فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني مَنْ أهل الجماعة؟ ومَنْ أهل الفرقة؟ ومَنْ أهل السُنّة؟ ومَنْ أهل البدعة؟ فقال: «ويحك! أمّا إذ سألتني فافهم عنّي، ولا عليك أن تسأل عنها أحداً بعدي؛ فأمّا أهل الجماعة: فأنا ومَنْ اتّبعني وإن قلّوا؛ وذلك الحقّ عن أمر الله وأمر رسوله، فأمّا أهل الفرقة: فالمخالفون لي ومَنْ اتّبعهم وإن كثروا...»(١) .
وهو كالصريح من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما خطب في مسجد الخيف: «ثلاث لا يغلُ عليهنّ قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمّة المسلمين، واللزوم لجماعتهم؛ فإنّ دعوتهم محيطة من ورائهم...»(٢) . إذ بعد أن
____________________
١ - كنز العمّال ١٦/١٨٣ - ١٨٤ ح ٤٤٢١٦، واللفظ له، الاحتجاج ١/٢٤٦.
٢ - تقدمت مصادره في ص: ١٥٧. ويحسن إثبات ما رواه في الكافي ١/٤٠٣:
قال: «محمد بن الحسن عن بعض أصحابنا عن علي بن الحكم عن الحكم بن مسكين عن رجل من قريش من أهل مكة قال: قال سفيان الثوري: اذهب بنا إلى جعفر بن محمد. قال: فذهبت معه إليه، فوجدناه قد ركب دابته، فقال له سفيان: يا أبا عبد الله حدثنا بحديث خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد الخيف... قال: فنزل، فقال له سفيان: مر لي =
كانت الإمامة الحقّة في أهل البيت (صلوات الله عليهم) - على ما ثبت في محلّه -؛ فجماعة أئمّة المسلمين هم جماعة أئمّة أهل البيت دون غيرهم من الفرق.
ويناسبه ما عن الثعلبي بسنده عن عبد الله البجلي قال: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ مات على حبّ آل محمد مات شهيداً...، ألا ومَنْ مات على حبّ آل محمد مات على السُنّة والجماعة...»(١) .
____________________
= بداوة وقرطاس، حتى أثبته، فدعا به، ثم قال: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد الخيف: «نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها، وبلغها من لم تبلغه ...: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، واللزوم لجماعتهم، فإن دعوتهم محيطة من ورائهم...» فكتبه سفيان، ثم عرضه عليه، وركب أبو عبد الله عليه السلام.
وجئت أنا وسفيان، فلما كنا في بعض الطريق قال لي: كما أنت حتى أنظر في هذا الحديث. فقلت له: قد والله ألزم أبو عبد الله رقبتك شيئاً لا يذهب من رقبتك أبداً. فقال: وأي شيء ذلك؟
فقلت له: ثلاث لا يغل عليهن قبل امرئ مسلم: إخلاص العمل لله قد عرفناه، والنصيحة لأئمة المسلمين. من هؤلاء الأئمة الذين يجب علينا نصيحتهم؟! معاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية ومروان بن الحكم وكل من لا تجوز شهادته عندنا، ولا تجوز الصلاة خلفهم؟!
وقوله: واللزوم لجماعتهم. فأي الجماعة؟! مرجئ يقول: من لم يصلّ ولم يصم ولم يغتسل من جنابة وهدم الكعبة ونكح أمه فهو على إيمان جبرئيل وميكائيل؟! أو قدري يقول: لا يكون ما شاء الله عز وجل، ويكون ما شاء إبليس؟! أو حروري يتبرأ من علي بن أبي طالب وشهد عليه بالكفر؟! أو جهمي يقول: إنما هي معرفة الله وحده ليس الإيمان شيء غيرها؟! قال: ويحك وأي شيء يقولون؟ قلت: يقولون إن علي بن أبي طالب والله الإمام الذي يجب علينا نصيحته، ولزوم جماعتهم أهل بيته. قال: فأخذ الكتاب فخرقه، ثم قال: لا تخبر بها أحداً».
١ - العمدة لابن البطريق/٥٤، تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي ٣/٢٣٨، تفسير الكشّاف ٣/٤٦٧ في تفسير قوله تعالى:( قل لا أسألكم عليه أجراً إلّا المودّة في القربى ) ، تفسير الرازي =
كما إنّه الأنسب بما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سأله رجل عن جماعة أُمّته، فأجابه بقوله: «جماعة أُمّتي أهل الحقّ وإن قلّوا»(١) .
وما عن عمرو بن ميمون قال: صحبت معاذاً باليمن...، ثمّ صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود، فسمعته يقول: عليكم بالجماعة؛ فإنّ يد الله على الجماعة، ويرغّب في الجماعة، ثمّ سمعته يوماً من الأيام وهو يقول: سيلي عليكم ولاة يؤخّرون الصلاة عن مواقيتها، فصلّوا الصلاة لميقاتها؛ فهو الفريضة، وصلّوا معهم؛ فإنّها لكم نافلة. قال: قلت: يا أصحاب محمد، ما أدري ما تحدّثوا. قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني بالجماعة وتحضّني عليها، ثمّ تقول لي: صلِّ الصلاة وحدك... قال: يا عمرو بن ميمون، قد كنت أظنّك أفقه أهل هذه القرية، تدري ما الجماعة؟ قال: قلت: لا. قال: إنّ جمهور الجماعة الذين فارقوا الجماعة؛ الجماعة ما وافق الحقّ وإن كنت وحدك. وفي طريق للحديث آخر: الجماعة ما وافق طاعة وإن كنت وحدك(٢) .
وبالجملة: قد أوضح أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في أيام حكمه القليلة كثيراً من الحقائق الدينية التي كان عامّة المسلمين في غفلة عنها.
مميّزاته الشخصية ساعدت على تأثيره وسماع دعوته
وقد ساعد على تأثيره (عليه السّلام) في رفع غفلتهم مميّزاته الشخصية؛ من السبق
____________________
= ٢٧/١٦٦ في تفسير الآية المتقدّمة، تفسير القرطبي ١٦/٢٣ في تفسير الآية المتقدّمة، ينابيع المودّة ١/٩١، و٢/٣٣٣، و٣/١٤٠، الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف/١٥٩ - ١٦٠، سعد السعود/١٤١، وغيرها من المصادر الكثيرة.
١ - المحاسن - للبرقي ١/٢٢٠، معاني الأخبار/١٥٤، تحف العقول عن آل الرسول/٣٤ مواعظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحكمه.
٢ - تاريخ دمشق ٤٦/٤٠٩ في ترجمة عمرو بن ميمون، واللفظ له، تهذيب الكمال ٢٢/٢٦٤ - ٢٦٥ في ترجمة عمرو بن ميمون، النصائح الكافية/٢١٩.
للإيمان، والقرابة القريبة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعظيم الأثر في رفع منار الإسلام بجهاده الفريد في سبيل الله تعالى، والعدل بين الرعية، والفناء في ذات الله تعالى، والشجاعة الخارقة، والتحبّب للعامّة أخلاقاً وسلوكاً، وما ظهر منه (صلوات الله عليه) من فنون العلم والمعرفة، والكرامات الباهرة، والأخبار الغيبية الصادقة... إلى غير ذلك ممّا يشهد بتميّزه عن عامّة الناس بنحو يناسب اختياره (عليه السّلام) واختيار أهل بيته لخلافة النبوّة من قبل الله (عزّ وجلّ).
كما إنّ ذلك من شأنه أن يوجب إعجاب كثير من الناس به وانشدادهم له عاطفيّاً، وتعلّقهم به، وموالاتهم له، وحبهّم إيّاه حبّاً قد يبلغ العشق.
وبعبارة أُخرى: إنّ شجرة التشيّع التي غرسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأقام الحجّة عليها، وثبت عليها الخاصة من أصحابه (رضي الله عنهم)، قد استطاع أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في فترة حكمه القصيرة المليئة بالمتاعب والمشاكل أن يسقيها وينميها، ويعمق جذورها، وينشر فروعها، بعد أن ذبلت وكادت تموت؛ نتيجة جهود الأوّلين، وسياستهم التي سبق التعرّض لها.
وإنّ النظر في كتاب نهج البلاغة - الواسع الانتشار - بتروٍّ واستيعاب ومقارنة، وبموضوعية بعيدة عن التكلّف والتعسّف، يكفي في استيضاح ذلك؛ فهو يصلح لأن يكون أطروحة مستوفية لأبعاد العقيدة الشيعيّة التي توارثتها الأجيال حتى عصرنا الحاضر، أمّا التراث والجهود الواردة عنه (عليه السّلام) في غير نهج البلاغة فالأمر فيها أظهر.
إيمان ثلّة من الخاصّة بدعوته (عليه السّلام) وتضحيتهم في سبيلها
ووجد (صلوات الله عليه) من ذوي المقام الرفيع في العقل والدين وقوّة الشخصية، والذين فرضوا احترامهم على المسلمين - بورعهم وأثرهم الحميد
في الإسلام - من تقبّلها بتفّهم وتبصّر وإخلاص وإصرار، وتبّنى حمل رايتها والدعوة لها متحدّياً قوى الشرّ والطغيان.
وتحمّل في سبيل ذلك ضروب المصائب والمحن، ومختلف أنواع التنكيل من السجن والتشريد، والقتل والتمثيل، والصلب وتشويه السمعة والتشنيع غير المسؤول، وانتهاك الحرمات العظام بوحشيّة مسرفة.
ثمّ تعاهد شجرتها من بعده بقيّة الأئمّة من ولده (صلوات الله عليهم). ودعمها الإمداد والتسديد الإلهي على طول الخطّ.
وبذلك بقيت هذه الدعوة الشريفة وانتشرت بين المسلمين، بل في جميع أنحاء العالم، وتوارثتها الأجيال جيلاً بعد جيل، مرفوعة الراية، مسموعة الصوت على طول المدّة، وشدّة المحنة، وتتابع الفتن.
بل لم يشهد التاريخ - فيما نعلم - دعوة حافظت على أصالتها ونقائها، واستمرت في مسيرتها وتوسّعها وانتشارها - رغم المعوّقات الكثيرة - كهذه الدعوة الشريفة.
العقبة الكؤود في طريق الدعوة احترام الأوّلين
نعم، كانت العقبة الكؤود التي تقف في طريقه (عليه السّلام) وطريق دعوته هذه هي إعجاب كثير من المسلمين بسيرة الشيخين أبي بكر وعمر، وحبّهم لهما حبّاً قد يبلغ حدّ التقديس؛ نتيجة العوامل التي سبق التعرّض لها، بحيث اضطر (صلوات الله عليه) إلى ترك بعض ما سنّاه في الدين على حاله مداراة لهم.
حتى إنّه ربما اتّخذ البعض ذلك شاهداً على إقراره لها وشرعيتها عنده (عليه السّلام)، وهو يجهل أو يتجاهل الظروف الحرجة التي كان (صلوات الله عليه) يمرّ بها ويعيشها، والتصريحات الكثيرة منه ومن الأئمّة من ولده (صلوات الله
عليهم) بعدم شرعيتها، والحديث في ذلك طويل لا يسعنا استيعابه.
خطبة له (عليه السّلام) يستعرض فيها كثيراً من البدع
إلاّ إنّه يحسن بنا أن نذكر خطبة له (صلوات الله عليه) رواها الكليني بطريق معتبر قال (عليه السّلام) فيها:
«وإنّما بدء وقوع الفتن من أهواء تُتبع وأحكام تُبتدع يُخالَف فيها حكم الله، يتولّى فيها رجال رجالاً، ألا إنّ الحقّ لو خلُص لم يكن اختلاف، ولو أنّ الباطل خلُص لم يخفَ على ذي حِجا، لكنّه يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيُمزجان فيُجللان معاً، فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه، ونجا الذين سبقت لهم من الله الحسنى.
إنّي سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير، ويهرم فيها الكبير، يجري الناس عليها، ويتّخذونها سُنّة، فإذا غُيّر منها شيء قيل: قد غُيّرت السُنّة، وقد أتى الناس منكراً، ثمّ تشتدّ البلية، وتُسبى الذريّة(١) ، وتدقهم الفتنة كما تدق النار الحطب، وكما تدق الرحا بثفالها، ويتفقّهون لغير الله، ويتعلّمون لغير العمل، ويطلبون الدنيا بأعمال الآخرة».
ثمّ أقبل بوجهه، وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته، فقال:
«قد عمل الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متعمّدين لخلافه، ناقضين لعهده، مغيّرين لسُنّته، ولو حملت الناس على تركه، وحوّلتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لتفرّق عنّي جندي حتى أبقى وحدي، أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي، وفرض إمامتي من كتاب الله
____________________
١- لعله إشارة إلى ما حدث بعد قتل الإمام الحسين (عليه السلام) من سبي عوائل وذراري أهل البيت (صلوات الله عليهم).
(عزّ وجلّ) وسُنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم (عليه السّلام) فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم(١) ، ورددت فدك إلى ورثة فاطمة (عليها السّلام)، ورددت صاع رسول
____________________
١ - فقد روي عن الإمام الباقر (عليه السّلام) أنّه قال: «كان المقام لازقاً بالبيت فحوّله عمر». راجع تهذيب الأحكام ٥/٤٥٤.
روى الفاكهي عن عائشة أنّ المقام كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سقع البيت. أخبار مكة ١/٤٥٥ ذكر موضع المقام من أوّل مرّة. وروى أيضاً عن عبد الله بن سلام: أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم مكة من المدينة فكان يصلّي إلى المقام وهو ملصق بالكعبة حتى توفّي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخبار مكة ١/٤٤٣ ذكر المقام وفضله، شفاء الغرام ١/٣٩٣ ذكر موضع المقام في الجاهلية والإسلام.
وقد نص غير واحد على أنّ عمر هو الذي أخّر المقام بعد أن كان ملصقاً بالبيت. الطبقات الكبرى ٣/٢٨٤ ذكر استخلاف عمر (رحمه الله)، الثقات - لابن حبان ٢/٢١٨، الكامل في التاريخ ٢/٥٦٢ أحداث سنة ثمان عشرة من الهجرة، فتح الباري ٨/١٢٩، تفسير ابن كثير ١/١٧٦، عمدة القاري ٤/٢٤١، التمهيد - لابن عبد البر ١٣/١٠٠، وغيرها من المصادر.
وقد روي عن عائشة أنّها قالت: إنّ المقام كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي زمن أبي ملتصقاً بالبيت ثمّ أخّره عمر. فتح الباري ٨/١٢٩، وتفسير ابن كثير ١/١٧٦، وكنز العمّال ١٤/١١٧ ح ٣٨١٠٢، الدرّ المنثور ١/١٢٠، وعلل الحديث - لابن أبي حاتم ١/٢٩٨ علل أخبار رويت في مناسك الحجّ وأدائه وثوابه ونحو ذلك، وقال سفيان بن عيينة: كان المقام في سقع البيت على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحوّله عمر إلى مكانه بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفسير ابن أبي حاتم ١/٢٢٦، واللفظ له، تفسير ابن كثير ١/١٧٦.
وروي عن ابن جريج أنّه قال: سمعت عطاء وغيره من أصحابنا يزعمون أنّ عمر أوّل مَنْ رفع المقام فوضعه موضعه الآن، وإنّما كان في قبل الكعبة. المصنّف - لعبد الرزاق ٥/٤٨ كتاب المناسك، باب المقام، أخبار مكة - للفاكهي ١/٤٥٤ ذكر موضع المقام من أوّل مرّة..، شفاء الغرام ١/٣٩٣ ذكر موضع المقام في الجاهلية والإسلام...
وروي عن سعيد بن جبير أنّه قال: كان المقام في وجه الكعبة، وإنّما قام إبراهيم حين ارتفع البنيان فأراد أن يشرف على البناء. قال: فلمّا كثر الناس خشي عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) =
الله صلى الله عليه وآله وسلم كما كان(١) ، وأمضيت قطائع أقطعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأقوام
____________________
= أن يطأوه بأقدامهم فأخرجه إلى موضعه هذا الذي هو به اليوم حذاء موضعه الذي كان به قدّام الكعبة. أخبار مكة ١/٤٥٤ ذكر موضع المقام من أوّل مرّة..، شفاء الغرام ١/٣٩٣ ذكر موضع المقام في الجاهلية والإسلام.
وقد فصّل الكلام في ذلك محمد طاهر الكردي ذاكراً جميع الروايات والأقوال في ذلك، وقد انتهى إلى أنّ الأصح كون عمر هو الذي أخّر المقام إلى موضعه اليوم. راجع التاريخ القويم ٤/٢٤ موضع المقام.
١ - قال الفضل بن شاذان: ورويتم أنّ عمر بن الخطاب زاد في مدّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثمّ زعمتم ذلك فضيلة لعمر. الإيضاح/١٩٨.
وقد ورد في أحاديث الجمهور أنّ لعمر صاعاً يختلف مقداره عن مقدار صاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ورد أنّ مقدار صاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمسة أرطال وثلث، بينما كان صاع عمر ثمانية أرطال؛ ولهذا وقع الخلاف بين فقهاء الجمهور في تحديد الصاع.
روى البيهقي عن الحسين بن الوليد قال: قدم علينا أبو يوسف من الحجّ فأتيناه، فقال: إنّي أريد أن افتح عليكم باباً من العلم همّني، تفحصت عنه فقدمت المدينة فسألت عن الصاع، فقالوا: صاعنا هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت لهم: ما حجّتكم في ذلك؟ فقالوا: نأتيك بالحجّة غداً. فلمّا أصبحت أتاني نحو من خمسين شيخاً من أبناء المهاجرين والأنصار مع كلّ رجل منهم الصاع تحت ردائه، كلّ رجل منهم يخبر عن أبيه أو أهل بيته أنّ هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنظرت فإذا هي سواء. قال: فعايرته، فإذا هو خمسة أرطال وثلث بنقصان معه يسير. فرأيت أمراً قويّاً، فقد تركت قول أبي حنيفة في الصاع، وأخذت بقول أهل المدينة....
قال الحسين: فحججت من عامي ذلك، فلقيت مالك بن انس فسألته عن الصاع. فقال: صاعنا هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: كم رطلاً هو؟ قال: إنّ المكيال لا يُرطل. هو هذا.
قال الحسين: فلقيت عبد الله بن زيد بن أسلم، فقال: حدّثني أبي عن جدّي أنّ هذا صاع عمر (رضي الله عنه). السنن الكبرى - للبيهقي ٤/١٧١ كتاب الزكاة، جماع أبواب زكاة الفطرة، باب ما دلّ على أنّ صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عياره خمسة أرطال وثلث.
وقال السمرقندي: ثمّ مقدار الصاع ثمانية أرطال عندنا. وقال أبو يوسف والشافعي: =
____________________
= خمسة أرطال وثلث رطل؛ لأنّ صاع أهل المدينة كذلك، وتوارثوه خلفاً عن سلف. لكنّا نقول: ما ذكرنا صاع عمر، ومالك من فقهاء المدينة، قال: إنّ صاع المدينة أخرجه عبد الملك بن مروان، فأمّا قبله كان ثمانية أرطال فكان العمل بصاع عمر أولى. تحفة الفقهاء ١/٣٣٨ - ٣٣٩، ومثله ما قاله أبو بكر الكاشاني. بدائع الصنائع ٢/٧٣.
وقد روى البخاري عن السائب أنّه قال: كان الصاع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدّاً وثلثاً بمدكم اليوم، وقد زيد فيه. صحيح البخاري ٨/١٥٣ كتاب الاعتصام بالكتاب والسُنّة. وقد رواه بهذا اللفظ النسائي. السنن الكبرى ٢/٢٩ كتاب الزكاة، باب كم الصاع.
وقد كان للحجّاج صاع يسمّى بالصاع الحجّاجي، وقد روي عن إبراهيم النخعي أنّه قال: وضع الحجّاج قفيزه على صاع عمر. شرح معاني الآثار ٢/٥٢ كتاب الزكاة، باب وزن الصاع، نصب الراية ٢/٥٢٠ أحاديث وآثار في مقدار الصاع.
وهذا الصاع يختلف عن مقدار الصاع عند أهل المدينة الذي تقدّم مقداره، قال ابن أبي ليلى: عيّرنا صاع المدينة فوجدناه يزيد مكيالاً على الحجّاجي. المصنّف - لابن أبي شيبة ٣/٩٤ كتاب الزكاة، قوله تعالى:( وَيَمْنَعُونَ الماعُونَ ) .
وقد روي عن موسى بن طلحة أنّه قال: الحجّاجي صاع عمر بن الخطاب. المصنّف - لابن أبي شيبة ٣/٩٤ كتاب الزكاة، قوله تعالى:( وَيَمْنَعُونَ الماعُونَ ) ، مسند ابن الجعد/٣٧٠، شرح معاني الآثار ٢/٥١ - ٥٢.
وكان الحجّاج يمنّ بهذا الصاع على أهل العراق ويقول: ألم أخرج لكم صاع عمر؟ المبسوط - للسرخسي ٣/٩٠.
وقال البيهقي: والصاع أربعة أمداد بمدّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - بأبي هو وأُمّي. قال في القديم: والصاع خمسة أرطال وثلث وزيادة شيء أو نقصانه. وقال قائل: الصاع ثمانية أرطال. فكانت حجّته أن قال: قال إبراهيم: وجدنا صاع عمر حجّاجي. قال: وقد عُيّر المكيال على عهد عمر فأراد ردّه فكأنّه نسيه..، وصاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيوت أزواجه والمهاجرين والأنصار وغيرهم من المسلمين قد رأينا عند أهل الثقة يتوارثونه لا يختلف فيه ويحمل على أطراف الأصابع، فهو كما وصفنا، فكيف جاز لأحد - وقلّ بيت إلّا وهو فيه - أن يدخل علينا في علمه التوهم؟! ولأنّ جاز هذا أن يدخل ليجوزنّ أن يقول ليس ذو الحليفة حيث زعمتم، ولا الجحفة ولا قرن، وإن عُلم المكيال بالمدينة لأعم من بعض =
لم تمضِ لهم ولم تنفذ(١) ،
____________________
= عُلم هذا؛ فرجع بعضهم وقال: ما ينبغي أن يدخل على أهل المدينة في علم هذا. معرفة السنن والآثار ٣/٢٦٩ - ٢٧٠.
وقال ابن حزم بعد ذكر الخلاف في الصاع: إنّنا لم ننازعهم في صاع عمر (رضي الله عنه) ولا في قفيزه، إنّما نازعناهم في صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولسنا ندفع أن يكون لعمر صاع وقفيز ومدّ رتّبه لأهل العراق لنفقاتهم وأرزاقهم، كما بمصر الويبة والأردب، وبالشأم المدى، وكما كان لمروان بالمدينة مدّ اخترعه، ولهشام بن إسماعيل مدّ اخترعه، ولا حجّة في شيء من ذلك...، ولو كان صاع عمر بن الخطاب هو صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نُسب إلى عمر أصلاً دون أن يُنسب إلى أبي بكر، ولا إلى أبى بكر أيضاًً دون أن يُضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فصح بلا شك أنّ مدّ هشام إنّما رتّبه هشام، وأنّ صاع عمر إنّما رتّبه عمر، وهذا إن صح أنّه كان هنالك صاع يُقال له: (صاع عمر) فإنّ صاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومدّه منسوبان إليه لا إلى غيره، باقيان بحسبهما.
وأمّا حقيقة الصاع الحجّاجي الذي عوّلوا عليه فإّننا روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق، عن مسدد، عن المعتمر بن سليمان، عن الحجّاج بن أرطاة قال: حدّثني مَنْ سمع الحجّاج بن يوسف يقول: صاعي هذا صاع عمر أعطتنيه عجوز بالمدينة.. وهذا أصل صاع الحجّاج، فلا كثر ولا طيب، ولا بورك في الحجّاج ولا في صاعه. المحلّى ٥/٢٤٣.
وحديث الجمهور عن الصاع كثير أثبتنا منه ما يناسب كلام أمير المؤمنين (عليه السّلام).
١ - روى ابن خزيمة عن الحارث بن بلال عن أبيه: أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ من معادن القبيلة الصدقة، وأنّه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع، فلمّا كان عمر قال لبلال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقطعك لتحجزه عن الناس، لم يقطعك إلّا لتعمل.
قال: فقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق. صحيح ابن خزيمة ٤/٤٤ كتاب الزكاة، باب ذكر أخذ الصدقة من المعادن، ومثله في السنن الكبرى - للبيهقي ٤/١٥٢ كتاب الزكاة، باب زكاة المعدن ومَنْ قال المعدن ليس بركاز، و٦/١٤٩ كتاب إحياء الموات، باب من أقطع قطيعة أو تحجر أرضاً ثمّ لم يعمّرها أو لم يعمّر بعضها، والمستدرك على الصحيحين ١/٤٠٤ كتاب الزكاة.
وروي عن عبد الله بن أبي بكر قال: جاء بلال بن الحارث المزني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستقطعه أرض. فقطعها له طويلة عريضة، فلمّا ولي عمر قال له: يا بلال، انّك استقطعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرضاً طويلة عريضة قطعها لك، وإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن ليمنع شيئاً =
ورددت دار جعفر إلى ورثته وهدمتها من المسجد(١) ، ورددت قضايا من
____________________
= يسأله، وإنّك لا تطيق ما في يديك. فقال: أجل. قال: فانظر ما قويت عليه منها فأمسكه، وما لم تطق فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين. فقال: لا أفعل والله، شيء أقطعنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عمر: والله لتفعلن. فأخذ منه ما عجز عن عمرته فقسمه بين المسلمين. السنن الكبرى - للبيهقي ٦/١٤٩ كتاب إحياء الموات، باب مَنْ أقطع قطيعة أو تحجّر أرضاً ثمّ لم يعمّرها أو لم يعمّر بعضها، واللفظ له، تاريخ دمشق ١٠/٤٢٦ - ٤٢٧ في ترجمة بلال بن الحارث، تاريخ المدينة ١/١٥٠ - ١٥١.
وروى ابن طاوس عن أبيه، عن رجل من أهل المدينة قال: قطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العقيق رجلاً واحداً، فلمّا كان عمر (رضي الله عنه) كثر عليه، فأعطاه بعضه وقطع سائره الناس. السنن الكبرى - للبيهقي ٦/١٤٩ كتاب إحياء الموات، باب مَنْ أقطع قطيعة أو تحجّر أرضاً ثمّ لم يعمّرها أو لم يعمّر بعضها.
١ - روي في غير واحد من المصادر أنّ عمر بن الخطاب وسّع المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أبى جماعة ممّن كانت دورهم في ضمن التوسعة، فهدمت وأُدخلت فيه على غير رضى منهم. وروي أنّ عثمان فعل ذلك أيضاً.
فقد روى الفاكهي أنّ المسجد كان مُحاطاً بالدور على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر فضاق على الناس؛ فوسّعه عمر واشترى دوراً فهدمها، وأعطى مَنْ أبى أن يبيع ثمن داره. فتح الباري ٧/١١٢.
وعن ابن جريج قال: كان المسجد الحرام ليس عليه جدران محيطة، إنّما كانت الدور محدقة به من كلّ جانب غير أنّ بين الدور أبواباً يدخل منها الناس من كلّ نواحيه، فضاق على الناس؛ فاشترى عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) دوراً فهدمها، وهدم على قرب من المسجد. وأبى بعضهم أن يأخذ الثمن وتمنّع من البيع فوضعت أثمانها في خزانة الكعبة حتى أخذوها بعد، ثمّ أحاط عليه جداراً قصيراً.
ثمّ كثر الناس في زمان عثمان بن عفان (رضي الله عنه) فوسّع المسجد، فاشترى من قوم، وأبى آخرون أن يبيعوا، فهدم عليهم فصيحوا به، فدعاهم فقال: إنّما جرّأكم عليّ حلمي =
الجور قُضي بها(١) ، ونزعت نساء تحت رجال بغير حق فرددتهن إلى أزواجهنّ، واستقبلت بهنّ الحكم في الفروج والأرحام(٢) ، وسبيت ذراري بني تغلب(٣) ،
____________________
= عنكم، فقد فعل بكم عمر هذا فلم يصح به أحد، فأحدثت على مثاله فصحتم بي. ثمّ أمر بهم إلى الحبس حتى كلّمه فيهم عبد الله بن خالد بن أسيد. تاريخ مكة المشرّفة والمسجد الحرام/١٥١ الباب الأوّل، تاريخ مكة المشرّفة، ذكر عمل عمر بن الخطاب وعثمان (رضي الله عنهم)، ومثله في فتوح البلدان ١/٥٣ مكة.
١ - راجع كتاب الغدير في الكتاب والسُنّة والأدب ٦/١٥٧، ١٦٤، ١٦٨، ١٧٢، ١٧٦، ١٨١، ١٩١، ١٩٢، ١٩٦، وغيره.
٢ - ربما يشير (عليه السّلام) إلى السبي غير الشرعي الذي حدث في عهد الخلفاء أو ما شرعه عمر من إمضاء الطلاق الثلاث في مجلس واحد، وردّ سبي العرب وغير ذلك ممّا يذكره الفقهاء.
٣ - بنو تغلب من نصارى العرب، قدم وفدهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستة عشر رجلاً مسلمين ونصارى عليهم صلب الذهب، فصالحهم رسول الله على أن يقرّهم على دينهم على أن لا يصبغوا أولادهم على النصرانية، وأجاز المسلمين منهم بجوائزهم. الطبقات الكبرى ١/٣١٦ وفد تغلب، البداية والنهاية ٥/١٠٨ وفد بني تغلب، السيرة النبوية ٤/١٧٨ وفد تغلب.
ولم يفوا بهذا الشرط، قال داود بن كردوس: ليس لبني تغلب ذمّة قد صبغوا دينهم. المحلّى ٦/١١٢ المسألة ٧٠١، السنن الكبرى - للبيهقي ٩/٢١٦ كتاب الجزية، باب نصارى العرب تضعف عليهم الصدقة.
وقد أبوا أن يدفعوا الجزية في زمن عمر، وقالوا: نحن عرب ولا نؤدّي ما تؤدّي العجم، ولكن خذ منّا كما يأخذ بعضكم من بعض، يعنون الصدقة. فقال عمر: لا. هذا فرض على المسلمين. فقالوا: فزد ما شئت بهذا الاسم، لا باسم الجزية. ففعل. فتراضى هو وهم على أنّ ضعّف عليهم الصدقة. السنن الكبرى - للبيهقي ٩/٢١٦ كتاب الجزية، باب نصارى العرب تضعّف عليهم الصدقة، وكتاب الأُم ٤/٣٠٠.
وروى زياد بن حدير الأسدي قال: قال علي (رضي الله عنه): «لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلنّ المقاتلة، ولأسبينّ الذريّة؛ فإنّي كتبت الكتاب بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبينهم على أن لا ينصّروا أبناءهم. راجع السنن الكبرى - للبيهقي ٩/٢١٧ كتاب الجزية، باب نصارى العرب تُضعّف عليهم الصدقة، وسنن أبي داود ٢/٤٢ كتاب الخراج والإمارة، باب في أخذ =
ورددت ما قسم من أرض خيبر(١) ، ومحوت دواوين العطايا، وأعطيت كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطي بالسويّة، ولم أجعلها دولة بين الأغنياء(٢) ،
____________________
= الجزية، وتهذيب الكمال ٩/٤٥٠ في ترجمة زياد بن حدير الأسدي، وكنز العمّال ٤/٦١٤ ح ١١٧٧٣، وغيرها من المصادر.
وعن علي بن أبي طالب أنّه قال: لئن تفرّغت لبني تغلب لأقتلنّ مقاتلتهم ولأسبينّ ذراريهم؛ فقد نقضوا، وبرئت منهم الذمّة حين نصّروا أولادهم. راجع المحلّى ٦/١١٢ المسألة:٧٠١، واللفظ له، المغني - لابن قدامة ١٠/٥٩١، كنز العمّال ٤/٥١٠ ح ١١٥٠٧، فتوح البلدان - للبلاذري ١/٢١٨ أمر نصارى بني تغلب بن وائل، الأموال - للقاسم بن سلام/٥٣٩ باب العشر على بني تغلب وتضعيف الصدقة عليهم.
١ - قال ابن جريج: أخبرني عامر بن عبد الله بن نسطاس عن خيبر، قال: فتحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانت جمعاً له حرثها ونخلها. قال: فلم يكن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رقيق، فصالح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهوداً على أنّكم تكفونا العمل ولكم شطر التمر على أنّي أقرّكم ما بدا لله ورسوله، فذلك حين بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن رواحة يخرص بينهم، فلمّا خيّرهم أخذت اليهود التمر.
فلم تزل خيبر بأيدي اليهود على صلح النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى كان عمر فأخرجهم. فقالت اليهود: أليس قد صالحنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كذا وكذا؟! فقال: بل على أنّه يقرّكم فيها ما بدا لله ورسوله، فهذا حين بدا لي أن أخرجكم، فأخرجهم، ثمّ قسّمها بين المسلمين الذين افتتحوها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يعطِ منها أحداً لم يحضر افتتاحها.
قال ابن جريج: وأخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير عن مقاضاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهود أهل خيبر على أنّ لنا نصف التمر ولكم نصفه وتكفونا العمل. راجع المصنّف - لعبد الرزاق ٨/١٠٢ - ١٠٣ كتاب البيوع، باب ضمن البذر إذا جاءت المشاركة، ومثله في مجمع الزوائد ٤/١٢٣ كتاب البيوع، باب المزارعة.
٢ - كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم بين المسلمين بالسواء، كما روي ذلك في قسمة الأنفال ببدر. السنن الكبرى - للبيهقي ٦/٣٤٨ كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب التسوية بين الناس بالقسمة.
ولكنّ عمر فاضل في العطاء بين المسلمين. فقد روى علي بن زيد عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب أنّ عمر بن الخطاب كتب المهاجرين على خمسة آلاف، والأنصار على أربعة آلاف، ومَنْ لم يشهد بدراً من أولاد المهاجرين على أربعة آلاف. المصنّف لابن أبي شيبة =
____________________
= ٧/٦١٨ كتاب الجهاد، ما قالوا في الفروض وتدوين الدواوين، والسنن الكبرى - للبيهقي ٦/٣٥٠ كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب التفضيل على السابقة والنسب.
وقد فرّق في العطاء بين زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد روى أبو الحويرث أنّ عمر فرض لعائشة وحفصة عشرة آلاف، ولأُمّ سلمة وأُمّ حبيبة وميمونة وسودة ثمانية آلاف ثمانية آلاف، وفرض لجويرية وصفية ستة آلاف ستة آلاف، وفرض لصفية بنت عبد المطلب نصف ما فرض لهنّ.
فأرسلت أُمّ سلمة وصواحبها إلى عثمان بن عفان فقلنَ له: كلّم عمر فينا؛ فإنّه قد فضّل علينا عائشة وحفصة، فجاء عثمان إلى عمر فقال: إنّ أُمّهاتك يقلنَ لك: سوِّ بيننا، لا تفضّل بعضنا على بعض. فقال: إن عشت إلى العام القابل زدتهنّ لقابل ألفين ألفين. فلمّا كان العام القابل جعل عائشة وحفصة في اثني عشر ألفا اًثني عشر ألف، وجعل أُمّ سلمة وأُمّ حبيبة في عشرة آلاف عشرة آلاف، وجعل صفية وجويرية في ثمانية آلاف ثمانية آلاف. المصنّف - لابن أبي شيبة ٧/٦١٧ كتاب الجهاد، ما قالوا في الفروض وتدوين الدواوين.
وقال ابن قدامة: إنّ أبا بكر سوّى بين الناس في العطاء وأعطى العبيد، وخالفه عمر ففاضل بين الناس. المغني - لابن قدامة ١١/٤٠٥.
وقد روي عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) أنّه أمر عمّار بن ياسر وعبيد الله بن أبي رافع وأبا الهيثم بن تيهان أن يقسّموا فيئاً بين المسلمين، وقال لهم: اعدلوا فيه، ولا تفضّلوا أحداً على أحد. فحسبوا، فوجدوا الذي يصيب كلّ رجل من المسلمين ثلاثة دنانير، فأعطوا الناس؛ فأقبل إليهم طلحة والزبير ومع كلّ واحد منهما ابنه، فدفعوا إلى كلّ واحد منهم ثلاثة دنانير. فقال طلحة والزبير: ليس هكذا كان يعطينا عمر، فهذا منكم أو عن أمر صاحبكم؟ قالوا: بل هكذا أمرنا أمير المؤمنين (عليه السّلام).
فمضيا إليه فوجداه في بعض أمواله قائماً في الشمس على أجير له يعمل بين يديه، فقالا: ترى أن ترتفع معنا إلى الظل؟ قال: «نعم». فقالا له: إنّا أتينا إلى عمّالك على قسمة هذا الفيء فأعطوا كلّ واحد منّا مثل ما أعطوا سائر الناس. قال: «وما تريدان؟». قالا: ليس كذلك كان يعطينا عمر. قال: «فما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطيكما؟»، فسكتا. فقال: «أليس كان صلى الله عليه وآله وسلم يقسم بالسوية بين المسلمين من غير زيادة؟». قالا: نعم. =
وألقيت المساحة(١) ، وسويت بين المناكح(٢) ، وأنفذت خمس الرسول كما أنزل الله (عزّ وجلّ) فرضه(٣) ، ورددت مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما كان
____________________
= قال: «أفسُنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالاتباع عندكما أم سُنّة عمر؟». قالا: سُنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دعائم الإسلام ١/٣٨٤.
١ - والظاهر أنّ مراده (عليه السّلام) الإشارة إلى جعل الخراج على الأرض نفسها؛ حيث ورد أنّه جعل الخراج على الأرضين التي تعلُ من ذوات الحبّ والثمار، والتي تصلح للغلّة من العام والعامر، وعطّل منها المساكن والدور التي هي منازلهم. تاريخ دمشق ٢/٢١٢ في ترجمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باب ذكر بعض ما ورد من الملاحم والفتن.
فقد ورد التعبير بذلك في قول أبو عبيد، وفي تأويل قول عمر أيضاً حين وضع الخراج ووظّفه على أهله من العلم أنّه جعله عاملاً عامّاً على كلّ مَنْ لزمته المساحة، وصارت الأرض في يده من رجل، أو امرأة، أو صبي، أو مكاتب، أو عبد، فصاروا متساويين فيها لم يستثنِ أحداً دون أحد. تاريخ دمشق ٢/٢١٢ في ترجمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باب ذكر بعض ما ورد من الملاحم والفتن.
وعن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي قال: وضع عمر بن الخطاب على أهل السواد على كلّ جريب يبلغه الماء عامراً وغامراً درهماً وقفيزاً من طعام، وعلى البساتين على كلّ جريب عشرة دراهم وعشرة أقفزة من طعام، وعلى الكروم على كلّ جريب أرض عشرة دراهم وعشرة أقفزة من طعام، وعلى الرطاب على كلّ جريب أرض خمسة دراهم وخمسة أقفزة طعام، ولم يضع على النخل شيئاًً وجعله تبعاً للأرض، وعلى رؤوس الرجال على الغني ثمانية وأربعين درهماً، وعلى الوسط أربعة وعشرين درهماً، وعلى الفقير اثني عشرة درهماً. المصنّف - لابن أبي شيبة ٣/١٠٦ كتاب الزكاة، ما يؤخذ من الكروم والرطاب والنخل وما يوضع على الأرض.
٢ - الظاهر أنّه تعريض بما ورد عن عمر من أنّه منع من تزويج ذوات الأحساب إلّا من ذوي الحسب. راجع المصنّف - لعبد الرزاق ٦/١٥٢، ١٥٤ كتاب النكاح، باب الأكفاء، والمصنّف - لابن أبي شيبة ٣/٤٦٦ كتاب النكاح، ما قالوا في الأكفاء في النكاح، والجرح والتعديل ٢/١٢٤ في ذكر إبراهيم بن محمد بن طلحة، والمغني - لابن قدامه ٧/٣٧٥، ونهى عن يتزوج العربي الأمة، المصنّف - لابن أبي شيبة ٣/٤٦٦ كتاب النكاح، ما قالوا في الأكفاء في النكاح.
٣ - روى جبير بن مطعم أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى سهم ذوي القربى إلى بني هاشم وبني =
____________________
= المطلب. المصنّف - لابن أبي شيبة ٧/٦٩٩ كتاب الجهاد، سهم ذوي القربى لمَنْ هو؟، السنن الكبرى - للبيهقي ٦/٣٦٥ كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب إعطاء الفيء على الديوان ومَنْ يقع به البداية، فتح الباري ٦/١٧٤.
وقد اختلف الحال بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روى جبير بن مطعم: أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقسم لعبد شمس ولا لبنى نوفل من الخمس شيئاً كما كان يقسم لبني هاشم وبني المطلّب، وأنّ أبا بكر كان يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير أنّه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطيهم، وكان عمر (رضي الله عنه) يعطيهم وعثمان من بعده منه. مسند أحمد ٤/٨٣ حديث جبير بن مطعم (رضي الله تعالى عنه)، واللفظ له، سنن أبي داود ٢/٢٦ كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوي القربى، السنن الكبرى - للبيهقي ٦/٣٤٢ كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب سهم ذوي القربى من الخمس، مجمع الزوائد ٥/٣٤١ كتاب الجهاد، باب قسم الغنيمة، وغيرها من المصادر الكثيرة.
وعن عبد الرحيم بن سليمان، عن أشعث، عن الحسن في هذه الآية( وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) قال: لم يُعطَ أهل البيت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخمس ولا عمر ولا غيرهم، فكانوا يرون أنّ ذلك إلى الإمام يضعه في سبيل الله وفي الفقراء حيث أراده الله. المصنّف - لابن أبي شيبة ٧/٧٠٠ كتاب الجهاد، سهم ذوي القربى لمَنْ هو؟
وعن سعيد المقبري قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى، فكتب إليه ابن عباس: إنّا كنّا نزعم أنّا نحن هم فأبى ذلك علينا قومنا. المصنّف - لابن أبي شيبة ٧/٧٠٠ كتاب الجهاد، سهم ذوي القربى لمَنْ هو؟ واللفظ له، مسند أحمد ١/٢٤٨ مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب (رضي الله تعالى عنه)، صحيح مسلم ٥/١٩٨ كتاب الجهاد والسير، باب النساء الغازيات يرضخ لهنّ، السنن الكبرى - للبيهقي ٦/٣٤٥ كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب ما جاء في مصرف أربعة أخماس الفيء، وغيرها من المصادر الكثيرة جدّاً.
وروى يزيد بن هرمز أنّ نجدة الحروري حين حجّ في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى، ويقول: لمَنْ تراه؟ قال ابن عباس: لقربي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضاً رأيناه دون حقّنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله. سنن أبي داود ٢/٢٦ كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوي القربى، واللفظ له، السنن الكبرى - للبيهقي ٦/٣٤٥ =
عليه(١) ، وسددت ما فُتح فيه من الأبواب وفتحت ما سُدّ منه(٢) ، وحرّمت المسح
____________________
= كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب ما جاء في مصرف أربعة أخماس الفيء، مسند أبي يعلى ٥/١٢٣.
وقال ابن عباس: إنّ عمر بن الخطاب دعانا إلى أن تنكح منه أيمناً، ونخدم منه عائلنا، ونقضي منه عن غارمنا، فأبينا ذلك إلّا أن يسلّمه لنا جميعاً، فأبى أن يفعل؛ فتركناه عليه. المصنّف - لابن أبي شيبة ٧/٦٩٩ كتاب الجهاد، سهم ذوي القربى لمَنْ هو؟ واللفظ له، مسند أبي يعلى ٤/٤٢٤، شرح معاني الآثار ٣/٣٠٣، وغيرها من المصادر.
وعن قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد بن الحنفية قال: اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال قائلون: سهم ذوي القربى لقرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال قائلون: لقرابة الخليفة. وقال قائلون: سهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للخليفة من بعده. فاجتمع رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدّة في سبيل الله فكانا على ذلك في خلافة أبى بكر وعمر (رضي الله عنهما). السنن الكبرى - للبيهقي ٦/٣٤٢ - ٣٤٣ كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب سهم ذوي القربى من الخمس، واللفظ له، المستدرك على الصحيحين ٢/١٢٨ كتاب قسم الفيء، المصنّف - لعبد الرزاق ٥/٢٣٨ كتاب الجهاد، باب ذكر الخمس وسهم ذي القربى، وغيرها من المصادر الكثيرة.
١ - فقد روي أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنى مسجده مربّعاً طوله وعرضه مئة ذراع، أو أقل من ذلك. وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ١/٢٦٢ الباب الرابع في ما يتعلّق بأمور مسجدها الأعظم النبوي، الفصل الثاني في ذرعه وحدوده التي يتميز بها عن سائر المسجد اليوم.
فزاد فيه عمر بن الخطاب فصار طوله أربعين ومئة ذراع وعرضه عشرين ومئة ذراع. وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ٢/٧٥ - ٧٦ الباب الرابع في ما يتعلّق بأمور مسجدها الأعظم النبوي، الفصل الثاني عشر في زيادة عمر (رضي الله عنه) في المسجد.
ثمّ زاد عثمان فيه أيضاً فجعل طوله ستين ومئة ذراع وعرضه خمسين ومئة ذراع. وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ٢/٨٥ الباب الرابع في ما يتعلّق بأمور مسجدها الأعظم النبوي، الفصل الرابع عشر في زيادة عثمان (رضي الله عنه).
٢ - كان لمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عهده ثلاثة أبواب، وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى الباب الرابع في ما يتعلّق بأمور مسجدها الأعظم النبوي ١/٢٥٩ الفصل الأوّل في أخذه صلى الله عليه وآله وسلم لموضع مسجده الشريف وكيفية بنائه، و٢/٢١٢ الفصل الثاني والثلاثون في أبواب المسجد وما سدّ منها وما بقي وما يحاذيها من الدور قديماً وحديثاً، أبواب المسجد.
فقد أحدث عمر بن الخطاب فيه باباً رابعاً فيه سُمّي بباب النساء. وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ٢/٧٨ الباب الرابع في ما يتعلّق بأمور مسجدها الأعظم النبوي، الفصل الثاني عشر في =
على الخفين(١) ،
____________________
= زيادة عمر (رضي الله عنه) في المسجد.
كما روي أنّه فتح باباً عند دار مروان بن الحكم، وبابين في مؤخّر المسجد. وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ٢/٧٧ الباب الرابع في ما يتعلّق بأمور مسجدها الأعظم النبوي، الفصل الثاني عشر في زيادة عمر (رضي الله عنه) في المسجد، وص ٢١٢ الفصل الثاني والثلاثون في أبواب المسجد وما سدّ منها وما بقي وما يحاذيها من الدور قديماً وحديثاً، أبواب المسجد.
١ - روي جواز المسح على الخفين عن جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود وابن عمر وأبو أبوب، بل نُسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الثابت عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) أنّه لا يجوز ذلك.
فقد روي عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه قال: «جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي (عليه السّلام) وفيهم علي (عليه السّلام)، وقال: ما تقولون في المسح على الخفين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على الخفين. فقال علي (عليه السّلام): قبل المائدة أو بعدها؟ فقال: لا أدري. فقال علي (عليه السّلام): سبق الكتاب الخفين، إنّما أنزلت المائدة قبل أن يُقبض بشهرين أو ثلاثة». تهذيب الأحكام ١/٣٦١.
وعن ابن عباس قال: إنّا عند عمر (رضي الله عنه) حين سأله سعد وابن عمر عن المسح على الخفين، فقضى عمر لسعد. فقال ابن عباس: فقلت: يا سعد قد علمنا أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على خفيّه، ولكنّ أقبل المائدة أم بعدها؟ قال: لا يخبرك أحد أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح عليهما بعد ما أُنزلت المائدة. فسكت عمر (رضي الله عنه). مسند أحمد ١/٣٦٦ مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، واللفظ له، السسن الكبرى - للبيهقي ١/٢٧٣ كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسح على الخفين.
ولكنّ عمر مع ذلك تمسّك به وكتب به، فقد روي أنّ يزيد بن وهب قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب في المسح على الخفّين ثلاثة أيام ولياليهنّ للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم. شرح معاني الآثار ١/٨٤ كتاب الطهارة، باب المسح على الخفّين كم وقته للمقيم والمسافر، واللفظ له. المصنّف - لابن أبي شيبة ١/٢٠٦ كتاب الطهارات، في المسح على الخفين، كنز العمّال ٩/٦٠٠ ح ٢٧٥٨٥.
روى رقية بن مقصلة قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السّلام) فسألته عن أشياء... فقلت له: ما تقول في المسح على الخفّين؟ فقال: «كان عمر يراه ثلاثاً للمسافر ويوماً وليلة للمقيم، وكان أبي لا يراه لا في سفر ولا حضر». فلمّا خرجت من عنده فقمت على عتبة الباب، فقال =
وحددت على النبيذ(١) ،
____________________
= لي: «أقبل». فأقبلت عليه، فقال: «إنّ القوم كانوا يقولون برأيهم، فيخطئون ويصيبون، وكان أبي لا يقول برأيه». وسائل الشيعة ١/٣٢٣.
وعن زاذان قال: قال علي بن أبي طالب لأبي مسعود: «أنت فقيه! أنت المحدّث أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخفّين؟». قال: أوَ ليس كذلك؟ قال: «أقبل المائدة أو بعدها؟». قال: لا أدري. قال: «لا دريت! إنّه مَنْ كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متعمّداً فليتبوأ مقعده من النار». كنز العمّال ٩/٦٠٧ ح ٢٧٦١٤، واللفظ له، ضعفاء العقيلي ٢/٨٦ في ترجمة زكريا بن يحيى الكسائي، ميزان الاعتدال ٢/٧٦ في ترجمة زكريا بن يحيى الكسائي الكوفي، لسان الميزان ٢/٤٨٤ في ترجمة زكريا بن يحيى الكسائي.
١ - وقد أحلّ عمر بن الخطاب النبيذ، فقد ورد عن عمرو بن ميمون قال: قال عمر (رضي الله عنه): إنا لنشرب من النبيذ نبيذاً يقطع لحوم الإبل في بطوننا من أن تؤذينا. السنن الكبرى - للبيهقي ٨/٢٩٩ كتاب الأشربة، باب ما جاء في وصف نبيذهم الذي كانوا يشربونه.
بل ورد عن نافع بن عبد الحارث أنّه قال: قال عمر: اشربوا هذا النبيذ في هذه الأسقية؛ فإنّه يقيم الصلب، ويهضم ما في البطن، وإنّه لن يغلبكم ما وجدتم الماء. المصنّف - لابن أبي شيبة ٥/٥٢٦ كتاب الأشربة، مَنْ كان يقول: إذا اشتدّ عليك فاكسره بالماء، واللفظ له. كنز العمال ٥/٥٢٢ ح ١٣٧٩٥.
وعن ابن عون قال: أتى عمر قوماً من ثقيف قد حضر طعامهم. فقال: كلوا الثريد قبل اللحم؛ فإنّه يسد مكان الخلل، وإذا اشتد نبيذكم فاكسروه بالماء، ولا تسقوه الأعراب. المصنّف - لابن أبي شيبة ٥/٥٢٦ كتاب الأشربة، مَنْ كان يقول: إذا اشتد عليك فاكسره بالماء. ومراده من ذلك منع إسكاره بخلطه بالماء.
ومن الطريف ما رواه الشعبي عن سعيد وعلقمة: أنّ أعرابياً شرب من شراب عمر، فجلده عمر الحد. فقال الأعرابي: إنّما شربت من شرابك! فدعا عمر شرابه فكسره بالماء، ثمّ شرب منه وقال: مَنّ رابه من شرابه شيء فليكسره بالماء. أحكام القرآن - للجصاص ٢/٥٨١.
وجاء رجل قد ظمئ إلى خازن عمر، فاستسقاه فلم يسقه، فأتي بسطيحة لعمر فشرب منه فسكر. فأُتي به عمر فاعتذر إليه، وقال: إنّما شربت من سطيحتك. فقال عمر: إنّما أضربك على السكر. فضربه عمر. شرح معاني الآثار ٤/٢١٨، واللفظ له. =
وأمرت بإحلال المتعتين(١) ، وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس
____________________
= المحلّى ٧/٤٨٦، فتح الباري ١٠/٣٤.
وعن سعيد بن ذي لعوة قال: أتي عمر برجل سكران فجلده، فقال: إنّما شربت من شرابك. فقال: وإن كان. شرح معاني الآثار ٤/٢١٨.
وقد ورد تحريمه في روايات الجمهور عن رسول الله. فقد روى ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحنتمة. قيل: وما الحنتمة؟ قال: الجرّة. يعني النبيذ. مسند احمد ٢/٢٧ مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب.
وقال عبد الله بن إدريس الكوفي: قلت لأهل الكوفة: يا أهل الكوفة، إنّما حديثكم الذي تحدّثونه في الرخصة في النبيذ عن العميان والعوران والعمشان. أين أنتم عن أبناء المهاجرين والأنصار؟! السنن الكبرى - للبيهقي ٨/٣٠٦ كتاب الأشربة، باب ما جاء في الكسر بالماء.
١ - وقد تواتر منع عمر عن المتعتين: متعة الحج ومتعة النساء. فقد قال في خطبة له: إنّ رسول الله هذا الرسول. وإنّ هذا القرآن هذا القرآن، وإنّهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما: إحداهما متعة النساء، ولا أقدر على رجل تزوّج امرأة إلى أجل إلّا غيّبته بالحجارة، والأخرى متعة الحج، افصلوا حجّكم من عمرتكم؛ فإنّه أتمّ لحجّكم، وأتمّ لعمرتكم. السنن الكبرى - للبيهقي ٧/٢٠٦ كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، واللفظ له، مسند أحمد ١/٥٢ مسند عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)، معرفة السنن والآثار ٥/٣٤٥، شرح معاني الآثار ٢/١٤٦ كتاب مناسك الحج، باب الإحرام النبوي بالحج أو العمرة، وغيرها من المصادر الكثيرة.
وقال جابر بن عبد الله: تمتّعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلمّا قام عمر قال: إنّ الله كان يحلّ لرسوله ما شاء بما شاء، وإنّ القرآن قد نزل منازله فأتمّوا الحجّ والعمرة لله كما أمركم الله، وابتوا نكاح هذه النساء. فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلّا رجمته بالحجارة. صحيح مسلم ٤/٣٨ كتاب الحجّ، باب في المتعة بالحجّ والعمرة، واللفظ له. أحكام القرآن - للجصاص ٢/١٩٣، تاريخ المدينة ٢/٧٢٠، وغيرها من المصادر.
وسأل رجل شامي عبد الله بن عمر عن متعة الحجّ، فقال: هي حلال. فقال له الشامي: إنّ أباك قد نهى عنها. فقال: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر أبي يُتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سنن الترمذي ٢/١٥٩ أبواب الحج، باب ما جاء في التمتع، واللفظ =
تكبيرات(١) ،
____________________
= له. وقال بعد ذكر الحديث: هذا حديث حسن صحيح. مسند أبي يعلى ٩/٣٤٢، تفسير القرطبي ٢/٣٨٨، وغيرها من المصادر.
١ - فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنّ التكبير على الجنازة خمساً.
قال عبد الأعلى: صلّيت خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبّر خمساً، فقام إليه أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى فأخذ بيده فقال: نسيت؟ قال: لا. ولكن صلّيت خلف أبي القاسم خليلي صلى الله عليه وآله وسلم، فكبّر خمساً، فلا أتركها أبداً. مسند أحمد ٤/٣٧٠ حديث زيد بن أرقم (رضي الله عنه)، واللفظ له، شرح معاني الآثار ١/٤٩٤ كتاب الصلاة، باب التكبير على الجنائز كم هو، المعجم الأوسط ٢/٢٢٨، وغيرها من المصادر.
وعن عبد العزيز بن حكيم قال: صلّيت خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبّر خمساً، ثمّ التفت فقال: هكذا كبّر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. مسند أحمد ٤/٣٧١ حديث زيد بن أرقم (رضي الله عنه).
وحدّث أيوب بن سعيد بن حمزة قال: صلّيت خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبّر خمساً ثمّ قال: صلّيت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جنازة فكبّر خمساً فلن ندعها لأحد. سنن الدارقطني ٢/٦٠ كتاب الجنائز، باب التسليم في الجنازة واحد والتكبير أربعاً وخمساً وقراءة الفاتحة.
وقال يحيى بن عبد الله التيمي: صلّيت خلف عيسى مولى لحذيفة في المدائن على جنازة فكبّر خمساً، ثمّ التفت إلينا فقال: ما وهمت ولا نسيت، ولكن كبّرت كما كبّر مولاي وولي نعمتي حذيفة بن اليمان، صلّى على جنازة وكبّر خمساً، ثمّ التفت إلينا فقال: ما نسيت ولا وهمت، ولكن كبّرت كما كبّر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلّى على جنازة فكبّر خمساً. مسند أحمد ٥/٤٠٦ حديث حذيفة بن اليمان، واللفظ له. مجمع الزوائد ٣/٣٤ كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنازة. سنن الدارقطني ٢/٦٠ كتاب الجنائز، باب التسليم في الجنازة واحد والتكبير أربعاً وخمساً وقراءة الفاتحة. تاريخ بغداد ١١/١٤٣ في ترجمة عيسى البزاز المدائني. وغيرها من المصادر.
فلمّا ولي عمر جعل التكبيرات أربعاً. السنن الكبرى - للبيهقي ٤/٣٧ كتاب الجنائز، باب ما يستدلّ به على أنّ أكثر الصحابة اجتمعوا على أربع، ورأي بعضهم الزيادة منسوخة. المصنّف - لعبد الرزاق ٣/٤٧٩ - ٤٨٠ كتاب الجنائز باب التكبير على الجنازة، المصنّف - لابن أبي شيبة ٣/١٨٦ كتاب الجنائز، مَنْ كان يكبّر على الجنازة خمساً. فتح الباري ٣/١٦٢، عون المعبود ٨/٣٤٣، وغيرها من المصادر.
وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم(١) ، وأخرجت مَنْ أُدخل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده ممّن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخرجه، وأدخلت مَنّ أُخرج بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممّن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدخله(٢) ، وحملت الناس
____________________
١ - روى الجمهور أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يجهر في الصلاة بـ (بسم الله الرحمن الرحيم). راجع السنن الكبرى - للبيهقي ٢/٤٦ - ٤٩ كتاب الصلاة، باب افتتاح القراءة في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم والجهر بها إذا جهر بالفاتحة، وسنن الدارقطني ١/٣٠٣ - ٣٠٥، ٣٠٨ كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة والجهر بها واختلاف الروايات، ونصب الراية/٤٤٢، ٤٤٤، والدراية - لابن حجر ١/١٣١، وغيرها من المصادر الكثيرة.
وعن ابن عباس أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يزل يجهر في السورتين ببسم الله الرحمن الرحيم حتى قبض. راجع سنن الدارقطني ١/٣٠٣ كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة والجهر بها واختلاف الروايات، وعمدة القارئ ٥/٢٨٨، ونصب الراية/٤٦٩، ٤٨٦، والدراية - لابن حجر ١/١٣٤، ١٣٦، وغيرها من المصادر.
وقال أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم فترك الناس ذلك. السنن الكبرى - للبيهقي ٢/٤٧ كتاب الصلاة، باب افتتاح القراءة في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم والجهر بها إذا جهر بالفاتحة.
وقد روى الجمهور أنّ أبا بكر وعمر وعثمان لم يجهروا به.
فقد روى حميد: إنّ أبا بكر كان يفتتح القراءة بالحمد لله ربّ العالمين. المصنّف - لابن أبي شيبة ١/٤٤٨ كتاب الصلاة، مَنْ كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
وقد روي عن الأسود أنّه قال: صلّيت خلف عمر سبعين صلاة فلم يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم. راجع المصنّف - لابن أبي شيبة ١/٤٤٩ كتاب الصلاة، مَنْ كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ونيل الأوطار - للشوكاني ٢/٢١٧.
وقد روى أنس أنّ أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله ربّ العالمين. المصنّف - لابن أبي شيبة ١/٤٤٧ كتاب الصلاة، مَنْ كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
٢ - قال الفيض: (وأخرجت مَنْ أُدخل) لعلّ المراد به أبو بكر وعمر؛ حيث دفنا في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. (أخرجه)، والمراد بإخراج الرسول إيّاهما سدّ بابهما عن المسجد. (وأدخلت مَنْ أُخرج) لعلّ المراد به نفسه (عليه السّلام)، وبإخراجه سدّ بابه وبإدخاله فتحه. الوافي ١٤/١٦ أبواب الخطب والرسائل.
على حكم القرآن وعلى الطلاق على السنة(١) ، وأخذت الصدقات على أصنافها وحدودها(٢) ، ورددت الوضوء، والغسل والصلاة إلى مواقيتها وشرائعها
____________________
١ - فقد روي عن ابن عباس أنّه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إنّ الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم. صحيح مسلم ٤/١٨٣ - ١٨٤ كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، المستدرك على الصحيحين ٢/١٩٦ كتاب الطلاق، السنن الكبرى - للبيهقي ٧/٣٣٦ كتاب القسم والنشوز، باب مَنْ جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك، المصنّف - لعبد الرزاق ٦/٣٩٢ كتاب الطلاق، باب المطلق ثلاثاً. وغيرها من المصادر الكثيرة جدّاً.
وقال أبو الصهباء لابن عباس: أتعلم إنّما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم. صحيح مسلم ٤/١٨٤ كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، السنن الكبرى - للبيهقي ٧/٣٣٦ كتاب القسم والنشوز، باب مَنْ جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك، المصنّف - لعبد الرزاق ٦/٣٩٢ كتاب الطلاق، باب المطلق ثلاثاً. وغيرها من المصادر الكثيرة جدّاً.
٢ - فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل الزكاة على الخيل، بل نهى عن ذلك. راجع المصنّف - لعبد الرزاق ٤/٣٣ - ٣٤ كتاب الزكاة، باب الخيل، التمهيد - لابن عبد البر ٤/٢١٥.
مع أنّ عمر فرض الزكاة عليه، قال حي بن يعلى أنّه سمع يعلى قال: ابتاع عبد الرحمن بن أمية - أخو يعلى - من رجل فرساً أنثى بمئة قلوص، فبدا له فندم البائع، فأتى عمر (رضي الله عنه)، فقال: إنّ يعلى وأخاه غصباني فرسي، فكتب عمر إلى يعلى بن أمية: أنّ الحقّ بي. فأتاه فأخبره. فقال: إنّ الخيل لتبلغ هذا عندكم؟! قال: ما علمت فرساً قبل هذه بلغ هذا. قال عمر: فنأخذ من كلّ أربعين شاة شاة ولا نأخذ من الخيل شيء؟ خذ من كلّ فرس دينار. قال: فضرب على الخيل ديناراً ديناراً. راجع السنن الكبرى - للبيهقي ٤/١١٩ - ١٢٠ كتاب الزكاة، باب مَنْ رأى في الخيل صدقة، واللفظ له، والمصنّف - لعبد الرزاق ٤/٣٦ كتاب الزكاة، باب الخيل، والاستذكار - لابن عبد البر ٣/٢٣٨، والتمهيد - لابن عبد البر ٤/٢١٦، ونصب الراية ٢/٤٢٢ - ٤٢٣، والمبسوط - للسرخسي ٢/١٨٨، وغيرها من المصادر الكثيرة.
كما فرض الزكاة على القطنية وهي العدس والحمص وأشباههم. راجع المصنّف لعبد =
ومواضعه، ورددت أهل نجران إلى مواضعهم(١) ، ورددت سبايا فارس وسائر الأمم إلى كتاب الله وسنّة نبيه (صلى الله عليه وآله)(٢) ، إذاً لتفرقوا عنّي.
____________________
= الرزاق ٤/١٢٠ كتاب الزكاة، باب الخضر، ٦/٩٩ كتاب الجهاد، صدقة أهل الكتاب، والسنن الكبرى - للبيهقي ٩/٢١٠ كتاب الجزية، باب ما يؤخذ من الذمّي إذا اتجر في غير بلده والحربي إذا دخل بلاد الإسلام بأمان، والمصنّف - لابن أبي شيبة ٣/٨٨ كتاب الزكاة، في نصارى بني تغلب ما يؤخذ منهم، ومعرفة السنن والآثار ٧/١٣٣، والاستذكار - لابن عبد البر ٣/٢٣١، ٢٥١، والتمهيد - لابن عبد البر ٢/١٢٦، وغيرها من المصادر الكثيرة.
وعلى عسل النحل. راجع المصنّف - لعبد الرزاق ٤/٦٢ كتاب الزكاة، باب صدقة العسل، والمصنّف - لابن أبي شيبة ٣/٣٣ كتاب الزكاة، في العسل هل فيه زكاة أم لا؟
وعلى الزيتون. راجع المصنّف - لابن أبي شيبة ٣/٣٣ كتاب الزكاة، في الزيتون فيه الزكاة أم لا؟
وعلى حلي النساء. راجع المصنّف - لابن أبي شيبة ٣/٤٤ كتاب الزكاة، في الحلي، وتلخيص الحبير ٦/١٩، كنز العمال ٦/٥٤٢ ح ١٦٨٧٥.
١ - روي أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم صالح أهل نجران على أن لا يجليهم من أرضهم، وأخذ منهم الجزية من المال الواسع. سبل السلام ٤/٦٣، وكتب لهم بذلك كتاب. المصنّف - لابن أبي شيبة ٨/٥٦٤ كتاب المغازي، ما ذكروا في أهل نجران.
ولمّا ولي عمر أجلاهم من أرضهم. السنن الكبرى ٩/٢٠٩ كتاب الجزية، باب ما جاء في تفسير أرض الحجاز وجزيرة العرب، المصنّف - لابن أبي شيبة ٨/٥٦٤ كتاب المغازي، ما ذكروا في أهل نجران، سبل السلام ٤/٦٣، فتح الباري ٥/٩.
وقد استنجد أهل نجران بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فجاؤوا إليه ومعهم قطعة أيدم فيه كتاب عليه خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا له: ننشدك الله كتابك بيدك، وشفاعتك بلسانك، إلّا ما رددتنا إلى نجران، فلم يفعل (عليه السّلام) شيء. تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢١٢، ونحوه في المصنّف - لابن أبي شيبة ٧/٤٨٣ كتاب الفضائل، ما ذكر في فضل عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)، تاريخ دمشق ٤٤/٣٦٤ في ترجمة عمر بن الخطاب، المغني - لابن قدامة ١١/٤٠٥، وقد كانت حادثة المباهلة المعروفة معهم.
٢ - لعلّه إشارة إلى منع عمر من سبي مشركي العرب.
قال اليعقوبي: وكان أوّل ما عمل به عمر أن ردّ سبايا أهل الردّة إلى عشائرهم، وقال: =
والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلّا في فريضة، وأعلمتهم أنّ اجتماعهم في النوافل بدعة، فتنادى بعض أهل عسكري ممّن يقاتل معي: يا أهل الإسلام، غُيّرَت سنّة عمر(١) ، ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعاً، ولقد خفت أن يثوروا في ناحية جانب عسكري...(٢) .
ويبدو من هذا الحديث أنه (صلوات الله عليه) لم يكن يصحر بكل ما عنده، لعدم تقبل العامّة لبعضه، بسب استحكام ولائهم للأولين، وحسن اعتقادهم بهم، نتيجة ما قاموا به من التعتيم الثقافي وغير ذلك مما تقدم الكلام فيه، بل يخص به الخاصّة من أهل بيته وشيعته.
____________________
= إنّي كرهت أن يصير السبي سنة على العرب. تاريخ اليعقوبي ٢/١٣٩ أيام عمر بن الخطاب.
وقال ابن الأثير: لما ولي عمر بن الخطاب قال: إنّه لقبيح بالعرب أن يملك بعضهم بعضاً وقد وسع الله (عزّ وجلّ) وفتح الأعاجم، واستشار في فداء سبايا العرب في الجاهلية والإسلام.... الكامل في التاريخ ٢/٣٨٢ أحداث سنة إحدى عشر من الهجرة، ذكر ردّة حضرموت وكندة، ومثله في تاريخ الطبري ٢/٥٤٩ أحداث سنة إحدى عشر من الهجرة، ذكر خبر حضرموت في ردّتهم، وإمتاع الأسماع ١٤/٢٥٠، وغيرهما من المصادر.
وقال الشعبي: لما قام عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال: ليس على عربي ملك.... السنن الكبرى - للبيهقي ٩/٧٤ كتاب السير، باب مَنْ يجري عليه الرق، واللفظ له، المصنّف - لعبد الرزاق ٧/٢٧٨ باب الأمة تغر الحرة بنفسها، المصنّف - لابن أبي شيبة ٧/٥٨٠ كتاب الجهاد، ما قالوا في سبي الجاهلية والقرابة، كنز العمال ٦/٥٤٥ ح ١٦٨٨٤، وغيرها من المصادر.
١ - فقد استفاضت النصوص بأنّ عمر شرع الجماعة في نافلة شهر رمضان وهي المعروفة بالتراويح. راجع صحيح البخاري ٢/٢٥٢ كتاب الصوم، كتاب صلاة التراويح، باب فضل مَنْ قام رمضان، والسنن الكبرى - للبيهقي ٢/٤٩٣ كتاب الصلاة، باب قيام شهر رمضان، والمصنّف - لعبد الرزاق ٤/٢٥٩ كتاب الصيام، باب قيام رمضان، وصحيح ابن خزيمة ٢/١٥٥ كتاب الصلاة، باب في بيان وتره صلى الله عليه وآله وسلم في الليلة التي بات ابن عباس عنده، ومعرفة السنن والآثار ٢/٣٠٤، ونصب الراية ٢/١٧٤، وغيرها من المصادر الكثيرة.
٢ - الكافي ٨/٥٨ - ٦٣.
وربما أجمل عليه السلام في حديثه حذراً من ردود الفعل التي يخشى أن تعيقه عن أداء وظيفته. ففي حديث سفيان: «عن فضيل بن الزبير قال: حدثني نقيع عن أبي كدينة الأزدي قال: قام رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فسأله عن قول الله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ) فيمن نزلت؟ قال: ما تريد؟ أتريد أن تغري بي الناس؟! قال: لا يا أمير المؤمنين، ولكن أحب أن أعلم. قال: اجلس، فجلس. فقال: اكتب: عامراً. اكتب: معمراً. اكتب: عمراً. اكتب: عماراً. اكتب: معتمراً. في أحد الخمسة نزلت. قال سفيان: قلت لفضيل: أتراه عمر؟ قال: فمن هو غيره»(١) .
فإذا كان مثل هذا الأمر الذي ظهر بعد ذلك حتى رواه الجمهور(٢ ) لا يسع أمير المؤمنين عليه السلام الإصحار به في تلك الظروف الحرجة، فكيف يكون الحال في غيره مما هو أشد وأقسى؟
ولذا حاول (صلوات الله عليه) أن يختار جماعة من خاصة أصحابه يلقي إليهم تلك الحقائق ويحملهم إياها في مجالس له خاصّة معهم أشبه بمجالس التدريس، لتبقى مخزونة في صدورهم، ويبثوها في الناس في الوقت المناسب وعندما يجدون الأرضية الصالحة لتقبلها.
ففي صحيح صالح بن ميثم التمار رحمه الله قال: «وجدت في كتاب ميثم رضي الله عنه يقول: تمسينا ليلة عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال لنا: ليس من
____________________
(١) تقريب المعارف ص: ٢٤٣.
(٢) صحيح البخاري ج: ٦ ص: ٤٦ كتاب تفسير القرآن: سورة الحجرات، ج: ٨ ص: ١٤٥ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع لقوله تعالى:( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ) . مسند أحمد ج: ٤ ص: ٦ حديث عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنها. سنن الترمذي ج: ٥ ص: ٦٣ أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سورة الحجرات. وغيرها من المصادر.
عبد امتحن الله قلبه بالإيمان إلا أصبح يجد مودتنا على قلبه، ولا أصبح عبد ممن سخط الله عليه إلا يجد بغضنا على قلبه، فأصبحنا نفرح بحب المؤمن لنا، ونعرف بغض المبغض لنا.
وأصبح محبنا مغتبطاً بحبنا برحمة من الله ينتظرها كل يوم، وأصبح مبغضنا يؤسس بنيانه على شفا جرف هار، فكان ذلك الشفا قد انهار به في نار جهنم. وكأن أبواب الرحمة قد فتحت لأصحاب الرحمة. فهنيئاً لأصحاب الرحمة رحمتهم، وتعساً لأهل النار مثواهم. إن عبداً لن يقصر في حبنا لخير جعله الله في قلبه.
ولن يحبنا من يحب مبغضنا، إن ذلك لا يجتمع في قلب واحد و( مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ) يحب بهذا قوماً، ويحب بالآخر عدوهم، والذي يحبنا فهو يخلص حبنا كما يخلص الذهب لا غش فيه.
نحن النجباء وأفراطنا أفراط الأنبياء، وأنا وصي الأوصياء، وأنا حزب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والفئة الباغية حزب الشيطان.
فمن أحب أن يعلم حاله في حبنا فليمتحن قلبه، فإن وجد فيه حب من ألّب علينا فليعلم أن الله عدوه وجبرئيل وميكائيل، والله عدو الكافرين»(١) .
ومن الظاهر أن مجالس التثقيف مساءً وفي بيت الإمام عليه السلام نفسه تختص بالخاصّة، ولا تكون مع العامّة. ولا سيما في تلك العصور.
ومن ثم عرف جماعة من ذوي المقام الرفيع بأنهم من خواص أصحابه الحاملين لتعاليمه وأسراره التي لا يسهل تقبلها على العامّة.
وكيف كان فقد بقي ولاء الأولين حاجزاً للكثيرين عن تقبل ما أوضحه
____________________
(١) الأمالي للطوسي ص: ١٤٨ - ١٤٩.
(صلوات الله عليه) من حقّ أهل البيت (عليهم السّلام)(١) ، بل سبباً للتشنيع والتشهير بشيعتهم، ومبرّراً لانتهاك حرماتهم في دمائهم وأموالهم وكرامتهم. إلّا أنّ إيمان الشيعة بقضيتهم كان أقوى من أن يقف ذلك في طريقه.
وبالجملة : كانت نتيجة جهود أمير المؤمنين (عليه السّلام)، وخاصة أصحابه ظهور دعوة التشيّع لأهل البيت (صلوات الله عليهم) المبتنية على أنّ الإمامة والخلافة حقّ يختصّ بهم. تبعاً للنصّ عليهم من الله (عزّ وجلّ) ورسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم.
____________________
(١) وربما صار ذلك عقدة بينه عليه السلام وبين بعض من كان في طاعته، بحيث كانوا في أزمة نفسية انفجرت في التحكيم، لتتشبث به كمبرر لتكفيره (صلوات الله عليه) والخروج عليه، وظهور فرقة الخوارج. كما يناسب ذلك.
أولاً: ضعف شبهتهم وظهور وهنها، لولا العقد التي تتحقق بها الأرضية الصالحة للتشبث بالشبه الضعيفة.
وثانياً: تقديسهم الشديد لأبي بكر وعمر، وعدم محاولتهم النظر في سلبياتهما. ولا سيما مع ما ورد من عناية عمر ببعضهم، كعبد الرحمن بن ملجم، حيث كتب لعاملة على مصر عمرو بن العاص أن قرّب دار عبد الرحمن بن ملجم من المسجد ليعلم الناس القرآن والفقه فوسع له. راجع لسان الميزان ج: ٣ ص: ٤٤٠ في ترجمة عبد الرحمن بن ملجم المرادي، والأنساب للسمعاني ج: ١ ص: ٤٥١ في التدؤلي، وتاريخ الإسلام ج: ٣ ص: ٦٥٣، في أحداث سنة أربعين من الهجرة، والوافي بالوفيات ج: ١٨ ص: ١٧٢ في ترجمة عبد الرحمن بن ملجم، وغيرها من المصادر.
وثالثاً: تميزهم بقراءة القرآن المجيد وتشبثهم بظواهر بعض آياته الكريمة، من دون تعريج على السنة النبوية الشريفة، التي كان أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) يركز عليها في إثبات حقه وحق أهل البيت (عليهم السلام)، وفي توجيه كثير من مواقفه.
حيث قد يوحي ذلك بعدم ألفتهم التعريج على السنة في الخروج عن الظواهر القرآن البدوية والجمع بينها، تأثراً بمواقف الأولين من السنة، وتركيزهم على القرآن وحده، حتى اشتهر عنهم قولهم: «حسبنا كتاب الله».
نعم لا يزيد ذلك على الاحتمال أو الظن، ويحتاج لمزيد من الفحص والتأمل قد يتيسر للباحثين، من أجل التعرف على التراكمات التي انفجرت لتتجسد في هذه الدعوة.
وهي تعتمد على الاستدلال والبرهان.
وذلك في مقابل ما كان عليه الجمهور من عدم اختصاص الإمامة والخلافة بأهل البيت (صلوات الله عليهم). وهو مدعوم باحترام الأوّلين احتراماً قد يبلغ حدّ التقديس، بحيث يكون ديناً يتديّن به؛ نتيجة العوامل التي سبق ويأتي التعرّض لها.
إيضاحه (عليه السّلام) لأحكام حرب أهل القبلة
الأمر الثاني: أنّ مقتل عثمان كان مفتاحاً للصراع الدموي على السلطة في الإسلام، ولظهور الانقسام في الأُمّة وظهور الفرق فيها.
وقد تنبّأ أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) بذلك في أحداث الشورى، نتيجة لما عنده من مكنون العلم. فقد روي عنه (عليه السّلام) أنّه قال لجماعة الشورى بعد أن ذكر حقّ أهل البيت (صلوات الله عليهم):
«اسمعوا كلامي، وعوا منطقي. عسى أن تروا هذا الأمر بعد هذا الجمع تنتضي فيه السيوف، وتخان فيه العهود حتى لا يكون لكم جماعة، وحتى يكون بعضكم أئمّة لأهل الضلالة، وشيعة لأهل الجهالة»(١) .
وقد سبق أنّه (عليه السّلام) قال لعثمان: «وإنّي أنشدك الله أن لا تكون إمام هذه الأُمّة المقتول؛ فإنّه كان يُقال: يُقتل في هذه الأُمّة إمام يفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة...»(٢) .
____________________
١ - شرح نهج البلاغة ١/١٩٥، واللفظ له، نهج البلاغة ٢/٢٣، تاريخ الطبري ٣/٣٠٠ أحداث سنة ثلاث وعشرين من الهجرة، قصّة الشورى، الكامل في التاريخ ٣/٧٤ أحداث سنة ثلاث وعشرين من الهجرة، ذكر قصّة الشورى.
٢ - تقدّم في/٢٦٨.
ومن الظاهر أنّ المسلمين لا عهد لهم بهذه الحروب ولا يعرفون أحكامها، وإنّما يعهدون حرب الكفّار من المشركين وأهل الكتاب، فتتحكّم فيها اجتهادات السلطة ونزواتها من دون تحديد للحقّ والباطل، والعدل والجور.
وفي الحقيقة: قد سبقت الحرب للمسلمين من أجل السلطة قبل ذلك عند ارتحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرفيق الأعلى؛ فإنّ بعض الحروب التي أطلق عليها حروب الردّة لم تكن في الحقيقة حروب ردّة، بل كانت من أجل تثبيت سلطة أبي بكر على ما ذكرناه في جواب السؤال الرابع من الجزء الثاني من كتابنا (في رحاب العقيدة).
إلاّ إنّ السلطة قد حاولت تشويه موقف المعارضة بإطلاق حروب الردّة عليها، كما إنّها تخبّطت في التعامل مع المعارضة عن عمد أو جهل، كما أشرنا لشيء من ذلك في المبحث الأوّل عند عرض نماذج من الانحراف في العهد الأموي(١) ، ومن ثمّ لم يعرف المسلمون شيئاً عن التعامل الإسلامي الحقّ في حرب أهل القبلة.
سيرته (عليه السّلام) في حروبه صارت سنّة للمسلمين
فكانت بيعة أمير المؤمنين (عليه السّلام) وتولّيه السلطة، ومباشرته لتلك الحروب التي ترتّبت على بيعته سبباً في وضوح أحكامه، وصارت سيرته (عليه السّلام) فيها علماً للمسلمين.
حتى قال أبو حنيفة: ما قاتل أحد علياً إلّا وعلي أولى بالحقّ منه، ولولا ما سار علي فيهم ما علم أحد كيف السيرة في المسلمين(٢) . وسُئل عن يوم الجمل.
____________________
١ - تقدّم في/٢٣٤ وما بعده.
٢ - بغية الطلب في تاريخ حلب ١/٢٩١ باب في ذكر صفين...، الفصل الثاني في بيان أنّ علياً (عليه السّلام) على الحقّ في قتاله معاوية (رحمه الله)، واللفظ له، مناقب أبي حنيفة - للخوارزمي ٢/٨٣ الباب الرابع والعشرون في ذكر ألفاظ جرت على لسانه فصارت أمثالاً بين الناس، مناقب أبي حنيفة - للكردري ٢/٧١.
فقال: سار علي فيه بالعدل، وهو علّم المسلمين السنّة في قتال أهل البغي(١) .
وقال تلميذه محمد بن الحسن: لو لم يقاتل معاوية علياً ظالماً له، متعدّياً باغياً كنّا لا نهتدي لقتال أهل البغي(٢) .
وقال الشافعي: لولا علي لما عُرف شيء من أحكام أهل البغي(٣) .
ولمّا أنكر يحيى بن معين على الشافعي استدلاله بسيرة أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في قتال البغاة، وقال: أيجعل طلحة والزبير بغاة؟! ردّ عليه أحمد بن حنبل وقال: ويحك! وأي شيء يسعه أن يضع في هذا المقام؟! وقال ابن تيمية: يعني: إنْ لم يقتد بسيرة علي في ذلك لم يكن معه سنّة من الخلفاء الراشدين في قتال البغاة(٤) .
وقد أوضح أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) بسيرته وأقواله في تلك الحروب أمرين:
إسلام الباغي يعصمه من الرق ويعصم ماله
أوّلهما : إنّ الباغي وإنْ هدر دمه دفعاً لشرّه، إلّا إنّ إسلامه يعصمه من الرق، ويعصم ماله الذي لم يقاتل به(٥) ، أو جميع ماله حتى ما قاتل
____________________
١ - مناقب أبي حنيفة - للخوارزمي ٢/٨٤ الباب الرابع والعشرون في ذكر ألفاظ جرت على لسانه فصارت أمثالاً بين الناس، مناقب أبي حنيفة - للكردري ٢/٧٢.
٢ - الجواهر المضية في طبقات الحنفية ٢/٢٦ في ترجمة محمد بن أحمد بن موسى بن داود الرازي البرزالي.
٣ - شرح نهج البلاغة ٩/٣٣١.
٤ - مجموع الفتاوى ٤/٤٣٨ مفصل اعتقاد السلف، فصل في أعداء الخلفاء الراشدين والأئمّة الراشدين.
٥ - شرح نهج البلاغة ١/٢٥٠، جامع بيان العلم وفضله - لابن عبد البر ٢/١٠٥، المصنّف - لابن أبي شيبة ٨/٧١٠ كتاب الجمل، مسير عائشة وعلي وطلحة والزبير، الدراية - لابن حجر ٢/١٣٩ باب البغاة، المحلّى ١١/١٠٣ حكم قتل أهل البغي، كنز العمال ١١/٣٣٦ ح ٣١٦٧٦ - ٣١٦٧٧. وغيرها من المصادر.
به(١) ، وليس هو كالكافر في ذلك.
وقد سبب ذلك له (عليه السّلام) إحراجاً في واقعة الجمل؛ لأنّ المسلمين لم يعهدوا التفريق بين الأمرين في حروبهم، إلّا أنّه استطاع أن يقنعهم حينما قال: «فأقرعوا على عائشة؛ لأدفعها إلى مَنْ تصيبه القرعة». فعرفوا خطأهم، وقالوا: نستغفر الله يا أمير المؤمنين(٢) .
وهذا من مظاهر أمانته (صلوات الله عليه) واهتمامه بتطبيق أحكام الله (عزّ وجلّ). فهو لم يندفع في الانتقام من محاربيه شفاءً لغيظه وتحكيماً لعاطفته، بل وقف عند الحكم الشرعي، لا من أجل مجاراة الناس، فإنّهم يجهلون الحكم المذكور، بل قياماً بوظيفته الشرعية، وأداءً لأمانته وما عهد إليه من تعريف الأُمّة بدينها، وإنّ سبّب ذلك إحراجاً له مع عسكره.
كما إنّه صار سبباً لزهد الناس في الجهاد معه في تلك الحروب التي بها تقرير مصير حكمه وتثبيت سلطته؛ لأنّ من أهمّ دواعي الجهاد عند عامة الناس هو الفوز بالغنائم والاستكثار منها.
والسلطة من بعده (عليه السّلام) وإن خرجت عن ذلك بسبب انحرافها، كما هو المعلوم بأدنى مراجعة للتاريخ، وأشرنا إلى بعض ذلك في المبحث الأوّل عند عرض نماذج من الانحراف في العهد الأموي، إلّا أنّ سيرته (عليه السّلام) صارت سبباً لظهور جورها في سيرته، وهو مكسب عظيم للإسلام؛ حيث ظهرت
____________________
١ - جواهر الكلام ٢١/٣٣٩ - ٣٤١.
٢ - شرح نهج البلاغة ١/٢٥١، واللفظ له، جامع بيان العلم وفضله - لابن عبد البر ٢/١٠٥، المصنّف - لابن أبي شيبة ٨/٧١٠ كتاب الجمل، مسير عائشة وعلي وطلحة والزبير، الدراية - لابن حجر ٢/١٣٩ باب البغاة، المحلّى ١١/١٠٣ حكم قتل أهل البغي، كنز العمال ١١/٣٣٦ ح ٣١٦٧٦ - ٣١٦٧٧، نصب الراية ٤/٣٦٣ باب البغاة، وصيّة سيّدنا علي (كرّم الله وجهه) يوم الجمل والحديث في ذلك. وغيرها من المصادر.
براءته من تلك السيرة الجائرة.
سقوط حرمة الباغي وانقطاع العصمة معه
ثانيهما: التأكيد على بغي الخارج على الإمام الحقّ، وسقوط حرمته، وخروجه عن ضوابط الإيمان والإسلام الحقّ مهما كان شأنه الديني والاجتماعي، كما يشير إلى ذلك ما يأتي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة.
وقال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): «أنا فقأت عين الفتنة. لم يكن ليجترئ عليها غيري. ولو لم أكُ فيكم ما قوتل أصحاب الجمل وأهل النهروان...»(١) .
وفي كتاب له (عليه السّلام) إلى معاوية: «وإنّ طلحة والزبير بايعاني، ثمّ نقضا بيعتي، وكان نقضهما كردّتهما، فجاهدتهما على ذلك حتى جاء الحقّ وظهر أمر الله وهم كارهون...»(٢) .
____________________
١ - بحار الأنوار ٣٣/٣٦٦، واللفظ له، كتاب السنّة - لعبد الله بن أحمد ٢/٦٢٧، حلية الأولياء ٤/١٨٦ في ترجمة علي بن أبي طالب، السنن الكبرى - للنسائي ٥/١٦٥ كتاب المناقب، ذكر ما خصّ به علي من قتال المارقين، ثواب من قاتلهم، إلّا إنّه ذكر أهل النهروان ولم يذكر أهل الجمل، بينما ذكرهم في كتاب خصائص أمير المؤمنين/١٤٦ ما خصّ به علي من قتال المارقين، المصنّف - لابن أبي شيبة ٨/٦٩٨ كتاب المغازي، ما ذكر في عثمان، إلّا إنّه كنّى عن عائشة وطلحة والزبير بـ: (فلان وفلان وفلان)، كنز العمال ١١/٢٩٨ ح ٣١٥٦٥، تاريخ اليعقوبي ٢/١٩٣ خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، كتاب سليم بن قيس/٢٥٦. وغيرها من المصادر.
وروي مبتوراً في علل الدارقطني ٤/٢٣ مسند علي بن أبي طالب، تاريخ دمشق ٤٢/٤٧٤ في ترجمة علي بن أبي طالب.
٢ - شرح نهج البلاغة ٣/٧٥، واللفظ له، و١٤/٣٦. الإمامة والسياسة ١/٨٠ كتاب علي إلى معاوية مرّة ثانية، تاريخ دمشق ٥٩/٢٨ في ترجمة معاوية بن صخر أبي سفيان، العقد الفريد ٤/٣٠٦ فرش كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم، خلافة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، أخبار علي ومعاوية، وقعة صفين/٢٩، المناقب - للخوارزمي/٢٠٢. وغيرها من المصادر.
ولما أرادوا كتابة عهد التحكيم بعد حرب صفين قيل له (عليه السّلام): أتقرّ أنّهم مؤمنون مسلمون؟ فقال (صلوات الله عليه): «ما أقرّ لمعاوية ولا لأصحابه أنّهم مؤمنون ولا مسلمون، ولكن يكتب معاوية ما شاء لنفسه وأصحابه، ويسمّي نفسه وأصحابه ما شاء»(١) .
بل ليس سقوط حرمة الباغي بهدر دمه فقط، كالزاني المحصن، بل ورد عنه (عليه السّلام) ما يناسب انقطاع العصمة بين الباغي وأهل الحقّ، فلا تجري عليه أحكام المسلمين بعد القتل مراسيم التجهيز الشرعية(٢) ، كما تجري على المسلمين.
وعلى هذا يبتني حديث الإمام الحسين (صلوات الله عليه) مع معاوية. قال اليعقوبي بعد أن ذكر مقتل حجر بن عدي الكندي وجماعته (رضوان الله عليهم): "وقال معاوية للحسين بن علي (عليهم السلام): يا أبا عبد الله علمت أنا قتلنا شيعة أبيك، فحنطناهم وكفناهم وصلينا عليهم ودفناهم. فقال الحسين: حججتك ورب الكعبة. لكنا والله إن قتلنا شيعتك ما كفناهم، ولا حنطناهم، ولا صلينا عليهم ولا دفناهم"(٣) .
وقيل: "ولما بلغ الحسن البصري قتل حجر وأصحابه قال: أصلوا عليهم، وكفنوهم، ودفنوهم، واستقبلوا بهم القبلة؟ قالوا: نعم. قال: حجوهم ورب الكعبة"(٤) .
____________________
(١) وقعة صفين/٥٠٩ - ٥١٠، واللفظ له، شرح نهج البلاغة ٢/٢٣٣، ينابيع المودّة ٢/٢٠.
(٢) تاريخ الطبري ٤/٦٦ أحداث سنة سبع وثلاثين من الهجرة: ذكر ما كان من خبر الخوارج. الكامل في التاريخ ٣/٣٤٨ أحداث سنة سبع وثلاثين من الهجرة: ذكر مقتل ذي الثدية. تاريخ ابن خلدون ٢ ق:٢/١٨١ أمر الخوارج وقتالهم.
(٣) تاريخ اليعقوبي ٢/٢٣١ وفاة الحسن بن علي، واللفظ له. الاحتجاج ٢/١٩. وسائل الشيعة ٢/٧٠٤ باب:١٨ من أبواب تغسيل الميت ح:٣.
(٤) الكامل في التاريخ ٣/٤٨٦ أحدث سنة إحدى وخمسين من الهجرة: ذكر مقتل حجر بن عدي وعمرو بن الحمق الخزاعي وأصحابهم، واللفظ له. تاريخ دمشق ٨/٢٧ في ترجمة أرقم بن عبد =
حيث يظهر من ذلك أن إجراء السلطان أحكام الإسلام على من يقتله ممن لا يعترف بشرعية سلطتة يكون حجة للمقتول على السلطان، لأنه لا يجتمع مع شرعية قتله له، وأن القتل والقتال من الإمام لمناوئية متى كان بحق ولم يكن تعدياً أوجب انقطاع العصمة بينهما، وسقوط الحرمة.
وقد صرّح بذلك زهير بن القين (رضوان الله عليه) في خطبته على عسكر الأمويين قبيل معركة الطف، حيث قال: "يا أهل الكوفة نذار لكم من عذاب الله نذار. إن حقاً على المسلم نصيحة أخيه المسلم. ونحن حتى الآن أخوة، وعلى دين واحد، وملة واحدة، ما لم يقع بيننا وبينكم السيف، وأنتم للنصيحة منا أهل. فإذا وقع السيف انقطعت العصمة، وكنا أمة وأنتم أمة..."(١) .
وبذلك يظهر موقف أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) من جميع من قاتله في حروبه، ونظرته إليهم، وتقييمه لهم.
الخلاصة في هدفه (عليه السّلام) من تولي السلطة
والمتحصل من جميع ما سبق: أن أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسلام) لم يقبل بالبيعة من أجل أن يَرجِع الحقّ إلى أهله، وتبقى السلطة في الإسلام في مسارها الذي أراده الله تعالى له. لأنه (عليه السّلام) كان على يقين من عدم تيسر ذلك، وأنه لابد من عود السلطة إلى الانحراف في مسارها.
وإنما كانت الثمرة المهمة لتوليه (عليه السّلام) الخلافة تنبيه الأمة لانحراف مسار السلطة في الإسلام، وظهور كثير من الأحكام الشرعية والحقائق التي يتوقف عليها بقاء دعوة الإسلام الحقّ، وسماع صوته، إقامة للحجة، حتى مع عود السلطة
____________________
= الله الكندي. تاريخ الطبري ٤/٢٠٧ أحدث سنة إحدى وخمسين من الهجرة: تسمية من قتل من أصحاب حجر (رحمه الله).
(١) تقدمت مصادره في/١٤١.
للانحراف الذي فرض على الإسلام بعد ارتحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرفيق الأعلى.
قيامه (عليه السّلام) بالأمر بعد عثمان بعهد من الله تعالى
ومن الطبيعي أن ذلك كله كان بعهد إليه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الله عز وجل( لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ ) (١) .
قال (عليه السّلام) في خطبته لما بويع: "ألا وإن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. والذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبلة، ولتغربلن غربلة، ولتساطن سوط القدر، حتى يعود أسفلكم أعلاكم، وأعلاكم أسفلكم. وليسبقن سابقون كانوا قصرو، وليقصرن سباقون كانوا سبقو. والله ما كتمت وشمة، ولا كذبت كذبة. ولقد نبئت بهذا المقام وهذا اليوم... حق وباطل. ولكل أهل. فلئن أمر الباطل لقديماً فعل. ولئن قلّ الحقّ فلربما ولعل. ولقلما أدبر شيء فأقبل"(٢) .
وذيل هذا الكلام مشعر بيأسه (عليه السّلام) من تعديل مسار السلطة في الإسلام، وبقاء الخلافة في موضعها الذي وضعها الله عز وجل فيه بعد أن خرجت عنه وأدبرت.
كلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة
وقال ابن أبي الحديد في التعقيب على كلام لأمير المؤمنين في الفتنة مذكور في نهج البلاغة: "وهذا الخبر مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد رواه كثير من المحدثين عن علي (عليه السّلام) أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: إن الله قد كتب عليك جهاد المفتونين كما كتب عليّ جهاد المشركين. قال: فقلت: يا رسول الله، ما هذه الفتنة
____________________
(١) سورة الأنفال الآية: ٤٢.
(٢) نهج البلاغة ١/٤٧-٤٨، واللفظ له. الكافي ٨/٦٧-٦٨.
التي كتب عليّ فيها الجهاد؟ قال: قوم يشهدون أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وهم مخالفون للسنة. فقلت: يا رسول الله فعلام أقاتلهم وهم يشهدون كما أشهد؟ قال: على الإحداث في الدين ومخالفة الأمر... فقلت: يا رسول الله لو بينت لي قليل.
فقال: إن أمتي ستفتن من بعدي، فتتأول القرآن وتعمل بالرأي، وتستحل الخمر بالنبيذ، والسحت بالهدية، والربا بالبيع، وتحرف الكتاب عن مواضعه، وتغلب كلمة الضلال. فكن جليس بيتك حتى تقلَّده. فإذا قلِّدتها جاشت عليك الصدور، وقلبت لك الأمور. تقاتل حينئذ على تأويل القرآن، كما قاتلت على تنزيله. فليست حالهم الثانية بدون حالهم الأولى.
فقلت: يا رسول الله فبأي المنازل أنزل هؤلاء المفتونين من بعدك، أبمنزلة فتنة أم بمنزلة رِدّة؟ فقال: بمنزلة فتنة يعمهون فيها إلى أن يدركهم العدل..."(١) ... إلى غير ذلك مما ورد عنهم (صلوات الله عليهم).
____________________
(١) شرح نهج البلاغة ٩/٢٠٦.
المقام الثاني
في مواجهة السلطة لجهود
أمير المؤمنين (عليه السّلام) وخاصته
بعد أن استولى معاوية على السلطة، وصفت له الأمور، وظّف قدراتِ الإسلام المعنوية والمادية لصالح حكمه، وتثبيت أركانه وإرساء قواعده، بأمل قيام دولة أموية تتولى قيادة المسلمين، وتتحكم في الإسلام لصالحها وصالح أصولها الجاهلية، مهما كانت الوسائل والنتائج.
اهتمام معاوية بالقضاء على خط أهل البيت (عليهم السّلام)
وكان همه الأكبر القضاء على خط أهل البيت (صلوات الله عليهم) الذي يمثل الإسلام الصحيح، ويذكر به، ويدعو له.
ويبدو أنه كان يرى في بدء الأمر أن سياسة الترغيب والترهيب تكفي في نجاح الخط الأموي، وفشل خط أهل البيت (صلوات الله عليهم)، وأن أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسلام) إنما نصره من نصره رغبة ورهبة حينما كان له السلطان، وكان بمقدوره أن يضر وينفع.
أما بعد أن قتل (عليه السّلام) وخرج السلطان عنه وعن أهل بيته - بحيث لا يُخافون ولا يُرجَون - فسوف يُنسى هو وأهل البيت من بعده، وتنسى معهم دعوة الحقّ - المتمثلة بخط أهل البيت (عليهم السّلام) وتموت بموته، وينفرد معاوية في الساحة، ولا يعيقه عن تحقيق هدفه شيء.
إدراك معاوية قوة خط أهل البيت (عليهم السّلام) عقائدي
لكنه فوجئ بأن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) قد أخذ موقعه من قلوب كثير من الناس، وتعلقوا به، وثبتوا على موالاته، والإيمان بدعوته، والتمسك به. حتى قال معاوية عنه (عليه السلام): "والله لوفاؤكم له بعد موته أعجب من حبكم له في حياته"(١) .
وأدرك أن أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسلام) قد أرسى دعوة ذات بعد عقائدي، تهدد مشروعه، وتقف حجر عثرة في طريقه، حيث ترتفع الأصوات من حملتها بالإنكار عليه وفضحه.
ولاسيما أن خط أهل البيت (صلوات الله عليهم) بما له من بُعد عقائدي يعتمد على أمور لها أهميتها في تركيز العقيدة وإرسائها وتجذره.
دعم العقل والدليل لخط أهل البيت (عليهم السّلام)
الأول: العقل والبرهان. حيث يملك الدليل الكافي على إثبات حقهم (عليهم السّلام). وقد نبّه أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) الناس إلى ذلك في فترة حكمه القصيرة.
ومن الأحاديث المهمة التي ذكرها (عليه السّلام) حديث الدار عند إنذار النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشيرته الأقربين في بدء الدعوة، حيث أعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أخوة أمير المؤمنين له صلى الله عليه وآله وسلم ووصيته وخلافته فيهم، وأمرَهم بأن يسمعوا له ويطيعوا(٢) .
____________________
(١) العقد الفريد ٢/٨٣ فرش كتاب الجمانة في الوفود: الوافدات على معاوية: وفود الزرقاء على معاوية، واللفظ له. تاريخ دمشق ٦٩/١٦٧ في ترجمة زرقاء بنت عدي بن مرة الهمدانية. بلاغات النساء/٣٤ في كلام الزرقاء بنت عدي.
(٢) تاريخ الطبري ٢/٦٣-٦٤ ذكر الخبر عما كان من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ابتداء الله تعالى ذكره إياه بإكرامه =
ومنها حديث الغدير في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد روى أحمد بن حنبل عن حسين بن محمد وأبي نعيم المعني قالا: حدثنا فطر عن أبي الطفيل قال: "جمع علي (رضي الله عنه) الناس في الرحبة. ثم قال لهم: أنشد الله كلّ امرئ مسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوم غدير خم ما سمع لما قام. فقام ثلاثون من الناس. وقال أبو نعيم: فقام ناس كثير، فشهدوا حين أخذ بيده فقال للناس: أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فهذا مولاه. اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه. قال: فخرجت وكأن في نفسي شيئ، فلقيت زيد بن أرقم فقلت له: إني سمعت علياً (رضي الله عنه) يقول كذا وكذ. قال: فما تنكر؟! قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك له"(١) .
وهذه المناشدة للناس مشهورة بين رجال الحديث تعرضنا لبعض الكلام فيها في جواب السؤال السابع من الجزء الأول من كتابنا (في رحاب العقيدة).
وقد دعم جهود أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في ذلك جماعة من أكابر الصحابة ممن كان معه سواءً كان ذلك منهم أيام عثمان - كما ذكرناه آنفاً - أم بعده في عهد أمير المؤمنين (عليه السّلام). ومن ذلك استجابتهم له في مناشدة الرحبة.
بل دعمه بعد ذلك بعض من لم يكن معه ولا على خطه من الصحابة، بعد أن أصيبوا بالإحباط، واستشعروا الوهن، لتولي معاوية الأمر وتقدمه عليهم،
____________________
= بإرسال جبرئيل (عليه السّلام) إليه بوحيه. الكامل في التاريخ ٢/٦٣ ذكر أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بإظهار دعوته. تاريخ دمشق ٤٢/٤٩، ٥٠ في ترجمة علي بن أبي طالب. شرح نهج البلاغة ١٣/٢١٠-٢١١. كنز العمال ١٣/١١٤ ح:٣٦٣٧١،/١٣١-١٣٣ ح:٣٦٤١٩. وغيرها من المصادر.
وقد أبدل ابن كثير في تفسيره (٣/٣٦٤) وصيي وخليفتي بـ (كذا وكذ)، وكذا فعل في كتابه البداية والنهاية (٣/٥٣) باب الأمر بإبلاغ الرسالة. وقد سبقه في ذلك الطبري في تفسيره (١٩/١٤٩) مع أنه رواه في تاريخه بدون تصرف.
(١) مسند أحمد ٤/٣٧٠ حديث زيد بن أرقم (رضي الله عنه).
فنشروا كثيراً من مناقب أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) الشاهدة بحقه وحق أهل بيته (عليهم السلام)، كرد فعل على ابتزاز معاوية للخلافة.
وأحد هؤلاء سعد بن أبي وقاص الذي كان ينال من أمير المؤمنين (عليه السّلام) في عهد رسول الله(١) صلى الله عليه وآله وسلم، وامتنع من بيعته حينما بايعه المسلمون بعد مقتل عثمان(٢) ، وكان ثالث ثلاثة تظاهروا عليه (عليه السّلام) في الشورى لصالح عثمان الذي صارت خلافته سبباً لنفوذ الأمويين. حتى انتهى الأمر إلى خلافة معاوية وتقدمه عليه وعلى غيره من المهاجرين والأنصار، ورأى بعينه سوء عاقبة مواقفه، فروى كثيراً من مناقب أمير المؤمنين (عليه السّلام). كما يظهر بالرجوع للمصادر الكثيرة(٣) .
____________________
(١) الأحاديث المختارة ٣/٢٦٧ فيما رواه مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه (رضي الله عنه). مجمع الزوائد ٩/١٢٩ كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه): باب منه جامع فيمن يحبه ومن يبغضه. مسند أبي يعلى ٢/١٠٩ مسند سعد بن أبي وقاص. تاريخ دمشق ٤٢/٢٠٤ في ترجمة علي بن أبي طالب. البداية والنهاية ٧/٣٨٣ أحداث سنة أربعين من الهجرة: شيء من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وغيرها من المصادر.
(٢) تاريخ الطبري ٣/٤٥٤ أحداث سنة خمس وثلاثين من الهجرة: خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أنساب الأشراف ٣/٧ بيعة علي بن أبي طالب (عليه السّلام). الكامل في التاريخ ٣/١٩١ أحداث سنة خمس وثلاثين من الهجرة: ذكر بيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. البداية والنهاية ٧/٢٥٣ أحداث سنة خمس وثلاثين من الهجرة: ذكر بيعة علي (رضي الله عنه) بالخلافة. تاريخ ابن خلدون ١/٢١٤. الفتوح لابن أعثم ٤/٤٤٠ ذكر من فشل عن البيعة وقعد عنه. شرح نهج البلاغة ٤/٩. وغيرها من المصادر.
(٣) راجع صحيح مسلم ٧/١٢٠ كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل علي (رضي الله عنه)، ومسند أحمد ١/١٨٢ في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه)، والمستدرك على الصحيحين ٣/٤٩٩-٥٠٠ كتاب معرفة الصحابة (رضي الله عنهم): مناقب سعد بن أبي وقاص، والسنن الكبرى ٥ كتاب الخصائص/١٠٨ ذكر منزلة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)،/١١٨، ١١٩ ذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما أنا أدخلته وأخرجتكم بل الله أدخله وأخرجكم، وسنن ابن ماجة ١/٤٥ باب اتباع سنة رسول (صلى الله عليه وسلم): فضل علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، ومجمع الزوائد ٩/١٠٧ كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب: باب قوله صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، والمصنف لابن أبي شيبة ٧/٤٩٦ كتاب الفضائل: فضائل علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، وكتاب السنة لابن أبي عاصم/٥٩٥، ٥٩٦، ٦١٠، ومسند أبي يعلى =
انشداد الناس عاطفياً لخط أهل البيت (عليهم السّلام)
الثاني: العاطفة، لما لأهل البيت (صلوات الله عليهم) من المكانة السامية في نفوس المسلمين، لقربهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولمؤهلاتهم الشخصية، ومثاليتهم العالية، الموجبة لانشداد الناس لهم.
خصوصاً بعد مرور تجربة أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في الحكم، وما استتبعها من أسباب تعلق الناس به التي تقدم التعرض لها.
ويزيد في ذلك ابتناء حكم معاوية على التجبر والطغيان والظلم والاستئثار، حيث يذكّر ذلك بعدل أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)، بنحو يوجب انشداد الناس له ولنهجه، والتنفر من معاوية ونهجه، ويتجلى به الفرق بين النهجين. (والضد يظهر حسنه الضد).
ظهور فشل نظرية عدم النص في الخلافة
الثالث: ظهور فشل نظرية عدم النص في الخلافة. فقد ظهر للعيان تردي الأوضاع حتى انتهت الخلافة إلى معاوية، وهو من الطلقاء، واستولى الأمويون ذوو الأثر السيء في الإسلام في عهده وعهد عثمان - من قبله - على مقدرات الإسلام والمسلمين، وانتهكوا من الحرمات ما لا يحصى.
كلّ ذلك بسبب انفراط أمر الخلافة، وعدم تحديد ضوابطها بعد خروجها بالقوة عن موضعها الذي جعله الله عز وجل فيه.
____________________
= ٢/١٠٩، ١٣٢ مسند سعد بن أبي وقاص، والدر المنثور ٢/٣٩، وغيرها من المصادر الكثيرة جداً.
تنبؤ سيدة النساء فاطمة (عليه السّلام) وغيرها بنتائج الانحراف
وسبق من سيدة النساء فاطمة الزهراء (صلوات الله عليه) أن قالت في مبدأ الانحراف، بعد التحاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرفيق الأعلى، وافتتان الأمة، وخروج الخلافة عن موضعها الذي وضعها الله تعالى فيه: "أما لعمرُ الله لقد لَقِحت فنظرة ريثما تنتج، ثم احتلبوها طلاع القعب دماً عبيطاً وذعافاً ممقر. هنالك يخسر المبطلون، ويعرف التالون غبّ ما أسس الأولون. ثم طيبوا عن أنفسكم نفس، واطمئنوا للفتنة جأش، وابشروا بسيف صارم، وهرج شامل، واستبداد من الظالمين، يدع فيئكم زهيداً وجمعكم حصيداً..."(١) .
وعن عبد الله بن عمر أنه قال: "لما بايع الناس أبا بكر سمعت سلمان الفارسي يقول: كرديد ونكرديد. أما والله لقد فعلتم فعلة أطمعتم فيها الطلقاء ولعناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فلما سمعت سلمان يقول ذلك أبغضته، وقلت: لم يقل هذا إلا بغضاً منه لأبي بكر". قال: "فأبقاني الله حتى رأيت مروان بن الحكم يخطب على منبر رسول الله. فقلت: رحم الله أبا عبد الله. لقد قال ما قال بعلم كان عنده"(٢) .
وفي حديث أبي الأشعث الصنعاني أن ثمامة كان على صنعاء، وكان من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فلما جاء نعي عثمان بكى بكاءً شديد، فلما أفاق قال: "هذا حين انتزعت خلافة النبوة من آل محمد وصارت ملكاً وجبرية، من غلب على كلّ شيء أكله"(٣) .
فإن ذلك يؤكد صدق مدعي النص. ولاسيما بعد كون المنصوص عليه
____________________
(١) راجع ملحق رقم (٢).
(٢) الإيضاح/٤٥٧-٤٥٨.
(٣) تاريخ دمشق ١١/١٥٨ في ترجمة ثمامة بن عدي القرشي.
هم أهل البيت (صلوات الله عليهم)، الذين هم أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخصهم به، وأعلمهم بالدين، وأحرصهم عليه، وأكملهم تطبيقاً له وعملاً به، وتفاعلاً معه.
وأولهم أمير المؤمنين (عليه السّلام) الذي رأوا في تجربته الحفاظ على الضوابط الدينية، والعدل والمثالية، ونشر المعارف الدينية، وظهور المعاجز والكرامات على يديه، ودعم التسديدات الإلهية له... إلى غير ذلك، بحيث يصلح عهده لأن يكون امتداداً للعهد النبوي الشريف.
انتشار التشيع إذا لم تزرع الألغام في طريقه
وهذه الأمور بمجموعها تقتضي تقبل المسلمين لدعوة التشيع وانتشارها بينهم إذا لم تزرع الألغام في طريقها وتوضع المعوقات أمامه.
وكأنه لذلك قال الإمام الصادق (صلوات الله عليه) - في حديث سليمان بن خالد: "إذا أراد الله بعبد خيراً نكت في قلبه نكتة بيضاء، فجال القلب يطلب الحقّ، ثم هو إلى أمركم أسرع من الطير إلى وكره"(١) . وقريب منه غيره.
الألغام التي زرعها معاوية في طريق التشيع
وبعد أن أدرك معاوية ذلك، وعرف حجم المشكلة التي تواجهه بأبعادها المتقدمة، فقد سلك في سبيل تنفيذ مخططه، والقضاء على خط أهل البيت (صلوات الله عليهم) والوقوف في وجه دعوتهم وتطويقها طريقين:
____________________
(١) المحاسن/٢٠١، واللفظ له. بحار الأنوار ٥/٢٠٤.
التنكيل بالشيعة
الأول: التنكيل بالشيعة وإسقاط حرمتهم كمسلمين، بحرمانهم من العطاء، وقتلهم، والتمثيل بهم، وسجنهم، وتشريدهم، وهدم دورهم... إلى غير ذلك مما تعرض له المؤرخون والباحثون عن سيرة معاوية والأمويين عموم. وقد أغرقوا في ذلك، حتى ورد عن أبي عبد الرحمن المقرئ أنه قال: "كانت بنو أمية إذا سمعوا بمولود اسمه علي قتلوه"(١) . وهو من الشيوع والوضوح بحيث لا ينبغي إطالة الكلام هنا في ذكر مفرداته. ولاسيما أنها أكثر من أن تستقصى.
أثر التنكيل بالشيعة على التشيع
وهذا وإن عاق نشر مذهب أهل البيت (صلوات الله عليهم) مؤقت، إلا أنه حيث لم يقض عليه، لكثرة الشيعة وإصرارهم، فقد خدمه على الأمد البعيد. لأن الظلامة والتضحيات تمنح دعوة الحقّ قوة ورسوخاً وفخر، وتوجب تعاطف الناس معه. خصوصاً إذا صدرت الظلامة من مثل الأمويين الذين عمّ ظلمهم، واستهتروا بالدين، فأبغضهم عامة المسلمين.
عود التحجير على السنة النبوية
الثاني: ما جرى عليه الأولون من التحجير على السنة النبوية. فعن عبد الله بن عامر اليحصبي قال: "سمعت معاوية على المنبر بدمشق يقول: أيها الناس إياكم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا حديث كان يذكر على عهد عمر. فإن
____________________
(١) تاريخ دمشق ٤١/٤٨١ في ترجمة علي بن رباح، واللفظ له. تهذيب الكمال ٢٠/٤٢٩ في ترجمة علي بن رباح بن قصير. سير أعلام النبلاء ٥/١٠٢ في ترجمة علي بن رباح. تاريخ الإسلام ٧/٤٢٧ في ترجمة علي بن رباح. تهذيب التهذيب ٧/٢٨١ في ترجمة علي بن رباح. الوافي بالوفيات ٢١/٧٢ في ترجمة اللخمي المصري علي بن رباح. وغيرها من المصادر.
عمر (رضي الله عنه) كان رجلاً يخيف الناس في الله..."(١) .
ومن كلامه: "يا أيها الناس أقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنتم متحدثون لا محالة فتحدثوا بما كان يتحدث به في عهد عمر..."(٢) .
وليس معنى التحجير المذكور الاقتصار على عدم رواية الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم، كما تضمنه هذا الحديث، بل جعل رواية الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم في خدمة مخطط معاوية ولو كان كذباً وافتراءً على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نظير ما حصل قبل ذلك، على ما سبق التعرض له. بل ربما يزيد عليه.
وذلك بأمور:
المنع من رواية الأحاديث المؤيدة لخط أهل البيت (عليهم السّلام)
أولها: المنع من رواية الأحاديث التي تخدم خط أهل البيت (عليهم السلام)، بذكر مناقبهم وفضائلهم، أو مثالب أعدائهم وسلبياتهم، كما يأتي في كلام المدائني ونفطويه وغيرهم.
بل بلغ الحال أن معاوية حاول بالترهيب والترغيب منع ابن عباس - مع ما له من مكانة علمية واجتماعية - من الحديث وتفسير القرآن المجيد على ما يناسب تفسير أهل البيت (صلوات الله عليهم) له.
____________________
(١) المعجم الكبير ١٩/٣٧٠ في ما رواه عبد الله بن عامر اليحصبي القارئ عن معاوية، واللفظ له. مسند أحمد ٤/٩٩ حديث معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنه). صحيح ابن حبان ٨/١٩٤ كتاب الزكاة: باب المسألة والأخذ وما يتعلق به من المكافأة والثناء والشكر: ذكر الزجر عن أن يأخذ المرء شيئاً من حطام هذه الدني. تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة ١/١٤٣ ح:١٢٩. وكذا في صحيح مسلم ٣/٩٥ كتاب الزكاة: باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له، مع تصرف.
(٢) مسند الشاميين ٣/٢٥١ فيما رواه يونس بن ميسرة عن معاوية، واللفظ له. تاريخ دمشق ٢٦/٣٨٢ في ترجمة العباس بن عثمان بن محمد أبي الفضل البجلي. الكامل لابن عدي ١/٥. كنز العمال ١٠/٢٩١ ح:٢٩٤٧٣.
محاورة معاوية مع ابن عباس
ففي حديث سليم بن قيس عن حوار بين معاوية وابن عباس قال: "قال معاوية: فإنا كتبنا في الآفاق ننهى عن ذكر مناقب علي وأهل بيته، فكفّ لسانك يا ابن عباس، وأربع على نفسك.
فقال له ابن عباس: أفتنهانا عن قراءة القرآن؟ قال: ل. قال: أفتنهانا عن تأويله؟ قال: نعم. قال: فنقرأه ولا نسأل عما عنى الله به؟! قال: نعم. قال: فأيما أوجب علينا قراءته أو العمل به؟ قال: العمل به. قال: فكيف نعمل به حتى نعلم ما عنى الله بما أنزل علين؟! قال: سل عن ذلك من يتأوله على غير ما تتأوله أنت وأهل بيتك. قال: إنما أنزل القرآن على أهل بيتي، فأسأل عنه آل أبي سفيان، أو أسأل عنه آل أبي معيط، أو اليهود والنصارى والمجوس؟!.
قال له معاوية: فقد عدلتنا بهم، وصيرتنا منهم. قال له ابن عباس: لعمري ما أعدلك بهم. غير أنك نهيتنا أن نعبد الله بالقرآن، وبما فيه من أمر ونهي، أو حلال أو حرام، أو ناسخ أو منسوخ، أو عام أو خاص، أو محكم أو متشابه. وإن لم تسأل الأمة عن ذلك هلكوا واختلفوا وتاهو.
قال معاوية: فاقرؤوا القرآن وتأولوه. ولا ترووا شيئاً مما أنزل الله فيكم من تفسيره، وما قاله رسول الله فيكم، وارووا ما سوى ذلك. قال ابن عباس: قال الله في القرآن:( يُرِيدُونَ لِيُطْفِئوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ) .
قال معاوية: يا ابن عباس، اكفني نفسك، وكف عني لسانك. وإن كنت لابد فاعلاً فليكن ذلك سر، ولا يسمعه أحد منك علانية. ثم رجع إلى منزله، فبعث إليه بخمسين ألف درهم"(١) .
____________________
(١) كتاب سليم بن قيس/٣١٥-٣١٦، واللفظ له. بحار الأنوار ٤٤/١٢٤-١٢٥.
وقد تقدم(١) عند الكلام في ردود الفعل لفاجعة الطف التعرض لشكوى الإمام الحسين (صلوات الله عليه) من ذلك في المؤتمر الذي عقده في الحج في أواخر أيام معاوية، ومحاولته (عليه السّلام) الرد عليه ببيان فضائل أهل البيت (صلوات الله عليهم)، ثم طلب روايتها ونشرها ممن حضر المؤتمر من مختلف بلاد المسلمين.
وقد تمّ على الأمد البعيد التغلب على هذه المشكلة، لأن فضائل أهل البيت عموماً وأمير المؤمنين (عليه السّلام) خصوص، من الكثرة والظهور بحيث يتعذر إخفاؤه، ومقامهم (صلوات الله عليهم) من الرفعة والجلالة بحيث لا يمكن تجاهله أو الحط منه.
وإن لم يبعد أن يكون قد ضاع من فضائلهم (عليه السّلام) ومناقبهم الكثير. خصوصاً على الجمهور، بحكم المعايير التي جروا عليها أخيراً في انتقاء الحديث، ولإعراضهم عن ثقافة أهل البيت (صلوات الله عليهم).
افتراء الأحاديث القادحة في أهل البيت (عليهم السّلام)
ثانيها: افتراء الأحاديث القادحة في أهل البيت (صلوات الله عليهم)، خصوصاً أمير المؤمنين (عليه السّلام). وقد ظهر من ذلك حديث موضوع كثير.
قال ابن أبي الحديد: "وذكر شيخنا أبو جعفر الإسكافي (رحمه الله تعالى) - وكان من المتحققين بموالاة علي (عليه السّلام)... - أن معاوية وضع قوماً من الصحابة وقوماً من التابعين على رواية أخبار قبيحة في علي (عليه السّلام) تقتضي الطعن فيه والبراءة منه، وجعل لهم على ذلك جعلاً يرغب في مثله. فاختلقوا ما أرضاه. منهم أبو هريرة، وعمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، ومن التابعين عروة بن الزبير..." ثم ذكر بعض النماذج من ذلك(٢) .
____________________
(١) راجع/١٠٤-١٠٥.
(٢) شرح نهج البلاغة ٤/٦٣ وما بعده.
موقف الجمهور من الأحاديث المذكورة
لكن الظاهر أن رفعة مقام أهل البيت (صلوات الله عليهم) حملت الجمهور على ترك روايتها وتدارسه، لأنها صارت عاراً على أحاديث الجمهور، ونقطة ضعف فيه، تستغل ضده، وتكون سبباً للتشنيع عليه.
ولاسيما مع التزام الجمهور بعد ذلك بعدالة جميع الصحابة - بمعنى كلّ من رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المسلمين وسمع حديثه - وتوثيقهم لكثر ممن روى تلك الأحاديث من التابعين.
لظهور أن تلك الأحاديث تكشف عن كذب الراوي لها من الصحابة، أو كذب الراوي لها من التابعين ممن ذهب الجمهور إلى توثيقه والاعتماد على حديثه، فأهملت تلك الروايات نوعاً في كتب الحديث.
ولم يبق منها إلا ما قد يعثر عليه المتتبع في بعض كتب التاريخ أو الاحتجاج أو التراجم أو غيرها مما تضمن ذكره، لا من أجل الاهتمام بروايتها وتدارسه، بل لغرض آخر. ولا يوجد منها في كتب الحديث إلا ما ندر.
قال ابن أبي الحديد: "وأما عمرو بن العاص فروي عنه الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما مسنداً متصلاً بعمرو بن العاص، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء. إنما وليي الله وصالح المؤمنين"(١) .
نعم يبدو أن بشاعة الحديث، وذهاب الجمهور أخيراً إلى عدالة جميع الصحابة، وتعظيمهم للصحيحين، وحكمهم بصحة جميع رواياتهم، كلّ ذلك اضطر المتأخرين إلى حذف كلمة (طالب) وجعل موضعها بياضاً(٢) ، أو إثبات
____________________
(١) شرح نهج البلاغة ٤/٦٤.
(٢) كما في صحيح البخاري ٧/٧٣ كتاب الأدب.
(فلان) بدلها(١) . ولابن حجر كلام طويل حول ذلك. فليراجع(٢) .
ومن هنا لم يكن لهذه المحاولة أثر مهمّ يمنع من انتشار التشيع، إلا في مثل بلاد الشام أيام الأمويين، حيث كانت معزولة عن العالم الإسلامي ثقافي، أو في البلاد البعيدة عن عواصم الثقافة الإسلامية في ظروف اشتداد الضغط الأموي، بحيث يمنع من انتشار ثقافة غير الأمويين بين عامة الناس، من دون أن يمنع من انتشار التشيع على الأمد البعيد.
افتراء الأحاديث في فضل الصحابة والخلفاء الأولين
ثالثها: افتراء الأحاديث في فضل الصحابة الذين هم على خلاف خط أهل البيت (صلوات الله عليهم)، وخصوصاً الخلفاء الأولين.
ففي حديث للإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر (عليه أفضل الصلاة والسلام) بعد أن أكد على نصّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حق أهل البيت (صلوات الله عليهم) في الخلافة، واستعرض ما جرى عليهم وعلى شيعتهم ومواليهم من الظلم وانتهاك الحرمات حتى قتل الإمام الحسين (عليه السّلام)، قال:
"ثم لم نزل - أهل البيت - نستذل ونستضام، ونقصى ونمتهن، ونحرم ونقتل ونخاف، ولا نأمن على دمائنا ودماء أوليائن. ووجد الكاذبون الجاحدون لكذبهم وجحودهم موضعاً يتقربون به إلى أوليائهم وقضاة السوء وعمال السوء في كلّ بلدة، فحدثوهم بالأحاديث الموضوعة المكذوبة، ورووا عنا ما لم نقله وما لم نفعله، ليبغضونا إلى الناس.
وكان عظم ذلك وكبره زمن معاوية بعد موت الحسن (عليه السّلام)... وحتى صار
____________________
(١) صحيح مسلم ١/١٣٦ كتاب الإيمان: باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم.
(٢) فتح الباري ١٠/٣٥٢.
الرجل الذي يذكر بالخير - ولعله يكون ورعاً صدوقاً - يحدث بأحاديث عظيمة عجيبة من تفضيل بعض من قد سلف من الولاة، ولم يخلق الله تعالى شيئاً منه، ولا كانت ولا وقعت، وهو يحسب أنها حق، لكثرة من قد رواها ممن لم يعرف بكذب، ولا بقلة ورع"(١) .
وقال ابن أبي الحديد: "وروى أبو الحسن علي بن محمد بن أبي سيف المدائني في كتاب (الأحداث)، قال: كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله بعد عام الجماعة أن برئت الذمة ممن روى شيئاً في فضل أبي تراب وأهل بيته، فقامت الخطباء في كلّ كورة وعلى كلّ منبر يلعنون علي، ويبرؤون منه، ويقعون فيه وفي أهل بيته... وكتب معاوية إلى عماله في جميع الآفاق أن لا يجيزوا لأحد من شيعة علي وأهل بيته شهادة.
وكتب إليهم أن انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه وأهل ولايته والذين يرون [يروون.ظ] فضائله ومناقبه، فأدنوا مجالسهم وقربوهم وأكرموهم، واكتبوا إليّ بكل ما يروي كلّ رجل منهم، واسم أبيه وعشيرته.
ففعلوا ذلك حتى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه، لما كان يبعثه إليهم معاوية من الصلات والكساء والحباء والقطائع، ويفيضه في العرب منهم والموالي. فكثر ذلك في كلّ مصر. وتنافسوا في المنازل والدني. فليس يجيء أحد مردود من الناس عاملاً من عمال معاوية، فيروي في عثمان فضيلة أو منقبة إلا كتب اسمه وقربه وشفعه. فلبثوا بذلك حيناً.
ثم كتب إلى عماله: إن الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كلّ مصر، وفي كلّ وجه وناحية. فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأولين.
____________________
(١) شرح نهج البلاغة ١١/٤٣، ٤٤. النصائح الكافية/١٥٢-١٥٣.
ولا تتركوا خبراً يرويه أحد من المسلمين في فضل أبي تراب إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة. فإن هذا أحب إلي وأقرّ لعيني، وأدحض لحجة أبي تراب وشيعته، وأشدّ عليهم، من مناقب عثمان وفضله.
فقرئت كتبه على الناس، فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة له. وجـدّ الناس في رواية ما يجري هذا المجرى، حتى أشادوا بذكر ذلك على المنابر. وألقي إلى معلمي الكتاتيب، فعلموا صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير الواسع، حتى رووه وتعلموه كما يتعلمون القرآن، وحتى علموه بناتهم ونساءهم وخدمهم وحشمهم. فلبثوا بذلك ما شاء الله... فظهر حديث كثير موضوع وبهتان منتشر. ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة.
وكان أعظم الناس في ذلك بلية القراء المراؤون والمستضعفون الذين يظهرون الخشوع والنسك، فيفتعلون الأحاديث، ليحظوا بذلك عند ولاتهم، ويقربوا مجالسهم، ويصيبوا به الأموال والضياع والمنازل.
حتى انتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلى أيدي الديانين الذين لا يستحلون الكذب والبهتان، فقبلوها ورووه، وهم يظنون أنها حق. ولو علموا أنها باطلة لما رووها ولا تدينوا به...".
قال ابن أبي الحديد بعد أن ذكر كلام المدائني بطوله: "وقد روى ابن عرفة المعروف بنفطويه - وهو من أكابر المحدثين وأعلامهم - في تاريخه ما يناسب هذا الخبر. وقال: إن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في أيام بني أمية، تقرباً إليهم بما يظنون أنهم يرغمون به أنوف بني هاشم"(١) .
ويبدو أن بعض رجال الجمهور قد أدرك ذلك. فهذا الفيروزآبادي صاحب القاموس يقول: "باب فضائل أبي بكر الصديق (رضي الله عنه). أشهر المشهورات
____________________
(١) شرح نهج البلاغة ١١/٤٤-٤٦.
من الموضوعات إن الله يتجلى للناس عامة ولأبي بكر خاصة، وحديث: ما صبّ الله في صدري شيئاً إلا وصبّه في صدر أبي بكر، وحديث: كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتاق الجنة قبل شيبة أبي بكر، وحديث: أنا وأبو بكر كفرسي رهان، وحديث: إن الله لما اختار الأرواح اختار روح أبي بكر. وأمثال هذا من المفتريات المعلوم بطلانها ببديهة العقل"(١) . وذكر نحوه العجلوني(٢) .
كما ذكر السيوطي ما يقرب من ثلاثين حديثاً في فضائل أبي بكر وحكم فيها بالوضع(٣) .
ومن الطبيعي أن ذلك من معاوية يستتبع كتمان أحاديث المثالب في الصحابة والامتناع أو المنع من تدارسها ونشره، بل تكذيبها واستهجانها.
كما أن من المعلوم أن المراد بالصحابة هم الذين على خلاف خط أهل البيت (صلوات الله عليهم)، ممن قاد عملية الانقلاب عليهم، وحرف مسار السلطة في الإسلام ومن سار في ركابهم. وفيهم جماعة كبيرة من المنافقين والمؤلفة قلوبهم وممن لم يسلم إلا رغبة أو رهبة.
وقد ذكرنا آنفاً أن وضع الأحاديث لصالح هذه الجماعة قد بدأ في العهود الأولى، كما يظهر من كلام أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) - المتقدم في أوائل المبحث الأول - وغيره.
وكان له أعظم الأثر في احترام هذه الجماعة، بل تقديسها والتدين بموالاته، والتغاضي عن سلبياتها وتجاهله، أو تكذيبه، أو تكلف توجيهه، بحيث لا يمنع من احترامها وتقديسها.
____________________
(١) سفر السعادة/١٤٣ خاتمة الكتاب.
(٢) كشف الخفاء ٢/٤١٩-٤٢٠.
(٣) اللآلي المصنوعة ١/٢٦١-٢٧٥ مناقب الخلفاء الأربعة.
وقد أدرك معاوية أهمية ذلك في مقاومة دعوة أهل البيت (صلوات الله عليهم) كما يظهر من كلامه المتقدّم؛ لأنّ مقاومة الدين بالدين أشدّ تأثيراً عليه وصداً له من مقاومته بالدنيا؛ فحاول تأكيد ذلك وتركيزه بحمل الناس على الإكثار من وضع الأحاديث في الاتجاه المذكور، ولاسيما مع وجود الأرضية الصالحة لتقبّله، بسبب كثرة الفتوح في عهد الأوّلين وتدهور الأوضاع بعد ذلك كما سبق.
بل كلّما تعاقبت الأجيال وامتدّ الزمن زادت أهمّية الموروثات العقائدية، وتجذّرت في النفوس، واشتدّ التعصّب له، والإصرار على تجاهل سلبياته، والتغاضي عن الأدلّة المضادّة لها.
وهذه الخطوة من معاوية في غاية الأهمية والخطورة من جهتين:
تقديس الأوّلين يقف حاجزاً دون تقبّل النصّ
الجهة الأولى: إنّها تقف حاجزاً دون تقبّل النصّ في الإمامة واستحقاق أهل البيت (صلوات الله عليهم) له كما سبق.
وقد كان معاوية - قبل رواية هذه الأحاديث وتأثيرها في تأكيد قدسية الأوّلين وشرعية خلافتهم، نظام الخلافة الذي جروا عليه عند جمهور المسلمين، - يحاول أن يشنّع على أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في كتبه إليه؛ لموقفه من الأوّلين، كما ذكرنا بعض مفردات ذلك في جواب السؤال الثالث من الجزء الثاني من كتابنا (في رحاب العقيدة).
وكذلك فعل مع الإمام الحسن (عليه السّلام) حينما أشار (صلوات الله عليه) في كتابه إليه إلى تظاهر قريش على أهل البيت، والشكوى من ذلك، فقد كتب إليه معاوية في جوابه: وذكرت تنازع المسلمين الأمر بعده، فصرّحت بتهمة أبي بكر
الصديق وعمر، وأبي عبيدة وصلحاء المهاجرين؛ فكرهت لك ذلك...(١) .
وكتب إليه في جواب كتاب آخر له (عليه السّلام) يتضمّن أيضاً الشكوى من تظاهر قريش: وذكرت وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتنازع المسلمين الأمر بعده، وتغلّبهم على أبيك، فصرّحت بتهمة أبي بكر الصديق وعمر الفاروق، وأبي عبيدة الأمين وحواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصلحاء المهاجرين والأنصار؛ فكرهت ذلك لك؛ إنّك امرؤ عندنا وعند الناس غير الظنين ولا المسيء ولا اللئيم، وأنا أحبّ لك القول السديد والذكر الجميل(٢) .
وإذا كان الردّ هكذا مع أمير المؤمنين والإمام الحسن (صلوات الله عليهم) قبل ظهور هذه الروايات المفتعلة، ومع علم جميع الأطراف كيف جرت الأمور، فكيف يكون الردّ على شيعتهم الذين أُسقطت حرمتهم، واتهموا بالتآمر على الدين، والخروج عن جماعة المسلمين في دعوتهم مع البعد الزمني عن الأحداث، ومحاولة تحريفها عن حقيقتها، وبعد ظهور الكمّ الهائل من الروايات المفتعلة التي كثفت هالة الإجلال والتقديس للأوّلين وخلافتهم حتى صارت خلافتهم وتقديسهم ديناً يتديّن به؟!
وكيف يسهل مع ذلك على جمهور المسلمين التجرّد عن التراكمات والموروثات، والنظر بموضوعية في النصوص الدالّة على اختصاص الإمامة بأئمّة أهل البيت (صلوات الله عليهم)، وبقيّة الشواهد والقرائن المؤيّدة لذلك، وفي السلبيّات المترتبة على تركه؟!
ضعف غلواء تقديس الشيخين في أواخر العهد الأموي
نعم، لا يبعد أن تكون غلواء التقديس للشيخين قد خفّت في أواخر
____________________
١ - شرح نهج البلاغة ١٦/٢٥.
٢ - شرح نهج البلاغة ١٦/٣٥، واللفظ له، مقاتل الطالبيين/٣٦.
العهد الأموي؛ لأنّ ظلم الأمويين وطغيانهم وسوء سلطانهم، واستهتارهم بالدين والقيم، كلّ ذلك بغّضهم للناس، وكان سبباً في تخفيف احترام المبادئ التي يتبنّونها، ومنها هذا التقديس الذي أكّدوا عليه.
كما إنّ ظلمهم لأهل البيت (صلوات الله عليهم) ولشيعتهم أوجب تعاطف الناس معهم، وسماعهم منهم، وتفاعلهم بوجهة نظرهم.
ولذا ظهر جماعة من العلماء والرواة في هذه الفترة ممّن يحترمهم الجمهور - في الجملة - يعرفون بالتشيّع، بل قد يُنسب لجماعة منهم النيل من الصحابة، ولبعضهم القدح بالشيخين خاصة، وقد ذكرنا جماعة منهم في جواب السؤال الثاني من الجزء الأوّل من كتابنا (في رحاب العقيدة).
مهاجمة العباسيين للأوّلين في بدء الدعوة
ولولا ذلك لما استطاع العباسيون أن يُقيموا أساس دعوتهم على استحقاقهم الخلافة بالقرابة وعلى الطعن في الشيخين، ويصرّحوا بعدم شرعية خلافة الأوّلين في بدء قيام دولتهم.
فقد دخل محمد المهدي بن المنصور العباسي على أبي عون عبد الملك بن يزيد عائداً له في مرضه - وكان من قدماء شيعة بني العباس، وحملة دعوتهم، والمشاركين في تشييد دولتهم - فأعجبه ما رآه منه وسمعه.
قال أبو جعفر الطبري: وقال: أوصني بحاجتك، وسلني ما أردت، واحتكم في حياتك ومماتك...، فشكر له أبو عون ودعا له، وقال: يا أمير المؤمنين حاجتي أن ترضى عن عبد الله بن أبي عون وتدعو به؛ فقد طالت موجدتك عليه. قال: فقال: يا أبا عون، إنّه على غير الطريق، وعلى خلاف رأينا ورأيك. إنّه يقع في الشيخين أبي بكر وعمر، يسيء القول فيهم. قال: فقال أبو عون: هو والله
يا أمير المؤمنين على الأمر الذي خرجنا عليه، ودعونا إليه. فإن كان قد بدا لكم فمرونا بما أحببتم؛ حتى نطيعكم(١) .
ولمّا انتصر جيش الدعوة العباسية ودخل الكوفة، وبويع أبو العباس السفاح، تكلّم داود بن علي - وهو على المنبر أسفل من أبي العباس بثلاث درجات - فحمد الله وأثنى عليه، وصلّى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثمّ قال: أيّها الناس، إنّه والله ما كان بينكم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خليفة إلّا علي بن أبي طالب، وأمير المؤمنين هذا الذي خلفي(٢) .
وخطب أبو مسلم الخراساني في السنة التي حجّ فيها في خلافة السفّاح خطبة طويلة، ومنها قوله: ثمّ جعل الحقّ بعد محمد (عليه السّلام) في أهل بيته، فصبر من صبر منهم بعد وفاة رسول الله (صلّى الله عليه)على اللأواء والشدّة، وأغضى على الاستبداد والأثرة.... والله، ما اخترتم من حيث اختار الله لنفسه ساعة قطّ، ومازلتم بعد نبيّه تختارون تيميّاً مرّة، وعدويّاً مرّة، وأمويّاً مرّة، وأسديّاً مرّة، وسفيانيّاً مرّة، ومروانيّاً مرّة... ألا إنّ آل محمد أئمّة الهدى، ومنار سبيل التقى...(٣) .
____________________
١ - تاريخ الطبري ٦/٤٠١ أحداث سنة تسع وستين ومئة من الهجرة، ذكر بعض سير المهدي وأخباره، واللفظ له، تاريخ دمشق ٣٧/١٨١ في ترجمة عبد الملك بن يزيد أبي عون الأزدي.
٢ - تاريخ الطبري ٦/٨٧ أحداث سنة مئة واثنين وثلاثين من الهجرة، خلافة أبي العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٥/٤١٦ أحداث سنة مئة واثنين وثلاثين من الهجرة، ذكر ابتداء الدولة العباسية وبيعة أبي العباس، أنساب الأشراف ٤/١٨٦ أمر قحطبة، عيون الأخبار ٢/٢٥٢ كتاب العلم والبيان: الخطب: خطبة لداود بن علي، مروج الذهب ٣/٢٤٨ - ٢٤٩ ذكر الدولة العباسية ولمع من أخبار مروان ومقتله وجوامع من حروبه وسيره: قول الراوندية في الخلافة، شرح نهج البلاغة ٧/١٥٥، وغيرها من المصادر.
٣ - شرح نهج البلاغة ٧/١٦١ - ١٦٢.
تراجع المنصور وتقديمه للشيخين
إلا إنّ المنصور الدوانيقي - الذي اشتدّ في القسوة مع العلويين - هو أوّل مَنْ تراجع منهم عن ذلك، فأقرّ خلافة الشيخين وتقديمهم، وإن كان ذلك لا يتناسب مع أُسس الدعوة العباسية كما هو ظاهر.
ويبدو أنّ إقدام المنصور على ذلك ليس من أجل ضغط الجمهور؛ لقوّة ولائهم للأوّلين، بل من أجل ثورات الحسنيين، بحجّة أنّهم الأقرب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنّهم من ذريّة أمير المؤمنين (عليه السّلام) الذي هو أوّل الخلفاء من الهاشميين، وظهور دعوى النصّ القاضي بإمامة خصوص أهل البيت من بني هاشم وغير ذلك.
فرأى المنصور أنّه بتقديم الشيخين، وإقرار خلافتهما، والتركيز على تقديسهما - كما صنع معاوية - يحيي دعوة الخطّ الموالي لهما ويستقطبه؛ لتقف في وجه العلويين، كما تقف حجر عثرة أمام دعوى النصّ المذكور؛ فقد قال: والله لأرغمن أنفي وأنوفهم، وأرفع عليهم بني تيم وعدي(١) .
وبذلك تأكّدت شرعية خلافة الشيخين واحترامهما وتقديسهما، وبدأ عهد تدوين السنّة النبوية على الصعيد العام، وظهرت المقالات والفرق، واشتدّ الضغط على أئمّة أهل البيت (صلوات الله عليهم)، وعلى الطالبيين عموماً، وعلى شيعتهم من قبل السلطة العباسية.
اعتراف المنصور ومَنْ بعده بشرعية خلافة الأمويين
بل يبدو إغراق المنصور ومَنْ بعده من حكّام العباسيين في ذلك، فأخذوا يعترفون بشرعية خلافة الأمويين بعد أن أمنوا منازعتهم لهم في السلطة؛ وذلك لتأكيد شرعية الخلافة بالقوّة من أجل إضعاف موقف العلويين.
____________________
١ - منهاج الكرامة/٦٩، واللفظ له، الصراط المستقيم ٣/٢٠٤.
فعن منصور بن مزاحم أنّه قال: سمعت أبا عبيد الله يقول: دخلت على أبي جعفر المنصور يوماً، فقال: إنّي أُريد أن أسألك عن شيء؛ فاحلف بالله أنّك تصدّقني. قال: فرماني بأمر عظيم؛ فقلت: يا أمير المؤمنين، وأدين الله بغير طاعتك وصدقك؟! أو أستحلّ أن أكتمك شيئاً علمته؟! فقال: دعني من هذا. والله لتحلفنّ. قال: فأشار إليّ المهدي أن أفعل؛ فحلفت.
فقال: ما قولك في خلفاء بني أمية؟ فقلت: وما عسيت أن أقول فيهم؟ إنّه مَنْ كان منهم لله مطيع، وبكتابه عامل، ولسنّة نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم متّبع؛ فإنّه إمام يجب طاعته ومناصحته، ومَنْ منهم على غير ذلك فلا.
فقال: جئت بها - والذي نفسي بيده - عراقية. هكذا أدركت أشياخك من أهل الشام يقولون؟ قلت: لا. أدركتهم يقولون: إنّ الخليفة إذا استخلف غفر الله له ما مضى من ذنوبه. فقال لي المنصور: إي والله، وما تأخّر من ذنوبه.
أتدري ما الخليفة؟ سبيله ما يُقام به من الصلاة، ويحجّ به البيت، ويجاهد به العدو. قال: فعدّد من مناقب الخليفة ما لم أسمع أحداً ذكر مثله.
ثمّ قال: لو عرفت من حقّ(١) الخلافة في دهر بني أُمية ما أعرف اليوم لرأيت من الحقّ أن آتي الرجل منهم حتى أضع يدي في يده، ثمّ أقول: مرني بما شئت. فقال له المهدي: فكان الوليد منهم؟ فقال: قبّح الله الوليد، ومَنْ أقعد الوليد خليفة. قال: فكان مروان منهم؟ فقال أبو جعفر: مروان؟ لله درّ مروان. ما كان أحزمه وأمرسه وأعفّه عن الفيء. قال: فلِمَ لمتموه وقتلتموه؟ فقال: للأمر الذي سبق في علم الله(٢) .
____________________
١ - أثبتنا هذه العبارة من تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء لوجود خلل في هذا الموضع من النصّ المطبوع من تاريخ دمشق.
٢ - تاريخ دمشق ٥٧/٣٣٣ في ترجمة مروان بن محمد بن مروان بن الحكم، واللفظ له، سير أعلام =
ومراد المهدي بالوليد هو الوليد بن يزيد الخليع الماجن، والذي برر ابن عمّه يزيد بن الوليد قتله بإلحاده وأفعاله(١) .
لكن قال شبيب بن شيبة: كنّا جلوساً عند المهدي، فذكروا الوليد، فقال المهدي: كان زنديقاً. فقام أبو علاثة الفقيه، فقال: يا أمير المؤمنين، إنّ الله (عزّ وجلّ) أعدل من أن يولّي خلافة النبوّة وأمر الأمّة زنديقاً. لقد أخبرني مَنْ كان يشهده في ملاعبه وشربه عنه بمروءة في طهارته وصلاته، فكان إذا حضرت الصلاة يطرح الثياب التي عليها المطايب المصبّغة، ثمّ يتوضأ...، فإذا فرغ عاد إلى تلك الثياب فلبسها، واشتغل بشربه ولهوه. فهذا فعال مَنْ لا يؤمن بالله. فقال المهدي: بارك الله عليك يا أبا علاثة(٢) .
ويبدو أنّ المهدي قد أقنع نفسه بذلك وجرى عليه. فقد قال البلاذري: وقال أمير المؤمنين المهدي وذكر الوليد: رحمه الله، ولا رحم قاتله؛ فإنّه كان ممّا مجتمعاً عليه. وقيل له: إنّ الوليد كان زنديقاً. فقال: إنّ خلافة الله أعزّ
____________________
= النبلاء ٦/٧٦ في ترجمة مروان بن محمد بن عبد الملك بن الحكم بن أبي العاص، تاريخ الإسلام ٨/٥٣٥ - ٥٣٦ في ترجمة مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن أبي العاص، وج ١٠/٥٥٠ في ترجمة أبي عبيد الله وزير المهدي وكاتبه، إلّا إنّه لم يذكر كلام المهدي، وغيرها من المصادر.
١ - الكامل في التاريخ ٥/٢٩١ - ٢٩٢ أحداث سنة ست وعشرين ومئة من الهجرة، ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص، تاريخ الطبري ٥/٥٧٠ أحداث سنة ست وعشرين ومئة من الهجرة، البداية والنهاية ١٠/١٥ أحداث سنة ست وعشرين ومئة من الهجرة، خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك، تاريخ خليفة بن خياط/٢٩٠ أحداث سنة ست وعشرين ومئة من الهجرة، خطبة يزيد بن الوليد طلباً للبيعة، تاريخ الإسلام ٨/٣١١ - ٣١٢ في ترجمة يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان، وغيرها من المصادر.
٢ - الكامل في التاريخ ٥/٢٩١ أحداث سنة ست وعشرين ومئة من الهجرة، واللفظ له، تاريخ ابن خلدون ٣/١٠٦ مقتل الوليد وبيعة يزيد، الأغاني ٧/٨٣ أخبار الوليد بن يزيد ونسبه وكنيته، دافع عنه ابن علاثة الفقيه لدى المهدي، نهاية الأرب في فنون الأدب ٢١/٢٩٥ - ٢٩٦ أحداث سنة (١٢٦) هـ، ذكر مقتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان وشيء من أخباره، وغيرها من المصادر.
وأجلّ من أن يولّيها مًنْ لا يؤمن به(١) .
وقد دخل على الرشيد ابن للغمر بن يزيد أخي الوليد بن يزيد الأموي المتقدّم. ولما عرّف نفسه للرشيد قال له: رحم الله عمّك الوليد، ولعن يزيد الناقص؛ فإنّه قتل خليفة مجمعاً عليه. ارفع حوائجك. فرفعها فقضاها(٢) .
ويبدو أنّ ثقافة السلطة العباسية أخذت بهذا الاتجاه، وفسح المجال لتمجيد الأمويين في محاولة تعميم هذه الثقافة في الجمهور؛ كردّ فعل على موقف أهل البيت (صلوات الله عليهم) وشيعتهم السلبي من الأمويين، خصوصاً بعد فاجعة الطفّ، واستغلال الخلاف المذهبي - في أمر الخلافة واحترام الأوّلين - بين الشيعة والجمهور؛ لتأكيد ولاء الجمهور للأمويين واحترامهم، مضادّة للشيعة.
تراجع المأمون عن موقف آبائه
ولمّا جاء عهد المأمون أدرك أنّ ظُلامة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسّلام) بلغت حدّاً أوجب تعاطف الناس معهم، ونقمتهم على العباسيين من أجل ذلك، ومن أجل ظلمهم وطغيانهم؛ فحاول امتصاص النقمة بالبيعة للإمام الرضا (صلوات الله عليه) على ما أوضحناه في أواخر الجزء الثالث من كتابنا (في رحاب العقيدة).
____________________
١ - أنساب الأشراف ٩/١٨٤ خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان، عند ذكر مقتله، وقريب منه في البداية والنهاية ١٠/٩ أحداث سنة ست وعشرين ومئة من الهجرة، مقتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك، وسير أعلام النبلاء ٥/٣٧٢ في ترجمة الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان، وتاريخ الإسلام ٨/٢٩١ في ترجمة الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الخليفة الفاسق، وغيرها من المصادر.
٢ - الكامل في التاريخ ٥/٢٩١ أحداث سنة ست وعشرين ومئة من الهجرة، واللفظ له، تاريخ ابن خلدون ٣/١٠٦ مقتل الوليد وبيعة يزيد، الأغاني ٧/٨٢ أخبار الوليد بن يزيد ونسبه، لعن الرشيد قاتليه (يزيد الناقص).
وخفّ الضغط على الشيعة نسبياً، فانتشرت ثقافة أهل البيت (صلوات الله عليهم)، وقام للشيعة كيانهم كأمر واقع مفروض في المجتمع، وأخذ بالظهور والاتّساع.
إلاّ إنّ الأمر لم يتجاوز ذلك؛ ليصل إلى القدح في الخطّ الآخر، بل بقي احترام الخطّ المخالف لأهل البيت (عليهم السّلام)، والتزام نهجه الفقهي ومعالمه المميّزة هو السمة العامّة في الدولة العباسية وثقافتها، إمّا لقناعة السلطة بذلك، أو مجاراة للجمهور الذي أخذت تلك الثقافة موقعها منه.
حتى إنّ المأمون لما رأى في معاوية ما استوجب اللعن نادى مناديه: برئت الذمّة من أحد من الناس ذكر معاوية بخير، أو قدّمه على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم...(١) . وأُنشئت الكتب إلى الآفاق بلعنه على المنابر.
فأعظم الناس ذلك وأكبروه، واضطربت العامّة منه؛ فأُشير عليه بترك ذلك، فأعرض عمّا همّ به(٢) .
تأكّد عدالة الصحابة وتقديس الشيخين في عهد المتوكّل
ثمّ جاء عهد المتوكّل الذي يبدو من الجمهور تعظيمه وتبجيله حتى قيل: إنّه أحيى السُنّة وأمات البدعة!(٣) ؛ فأعلن النصب والعداء لأمير المؤمنين
____________________
١ - مروج الذهب ٤/٤٤ ذكر خلافة المأمون، المأمون وحديث معاوية، وقريب منه في تاريخ الطبري ٧/١٨٧ في أحداث سنة إحدى عشرة ومئتين، والكامل في التاريخ ٦/٤٠٦ في أحداث سنة إحدى عشرة ومئتين، وتاريخ الإسلام ١٥/٦ - ٧ في أحداث سنة إحدى عشرة ومئتين، تشيّع المأمون.
٢ - مروج الذهب ٤/٤٤ - ٤٥ ذكر خلافة المأمون، المأمون وحديث معاوية.
٣ - راجع تاريخ الإسلام ١٧/١٣ أحداث سنة أربع وثلاثين ومئتين من الهجرة، إظهار المتوكّل للسُنّة، والبداية والنهاية ١٠/٣٨٧ أحداث سنة سبع وأربعين ومئتين من الهجرة، في ترجمة المتوكّل على الله، وتاريخ بغداد ٧/١٨٠ في ترجمة جعفر أمير المؤمنين المتوكّل على الله، والوافي بالوفيات ١١/١٠١ في ترجمة المتوكّل على الله جعفر بن محمد أبي الفضل، وفوات الوفيات ١/٢٨٩ في ترجمة المتوكّل العباسي، وغيرها من المصادر.
(صلوات الله عليه) ولذريته، وفعل الأفاعيل في سبيل ذلك، ونشط في عهده الفقهاء والرواة ممّنْ هم على خلاف خطّ أهل البيت (عليهم السّلام)؛ وبذلك عاد مسار ثقافة السلطة إلى ما كان عليه في عهد المنصور ومَنْ بعده.
ودوّنت في قرنه - وهو القرن الثالث - أصول كتب الحديث عند الجمهور وصحاحهم، وشيّدت عقيدتهم في تقديم الأوّلين وفي عدالة الصحابة عموماً، بما في ذلك معاوية وأمثاله.
وتأكّد ذلك عند العامّة على مرّ الزمن وتجذّر فيهم، بل أغرقوا فيه حتى ربما ضاقت السلطة ببعض مواقفهم وممارساتهم.
ففي سنة مئتين وسبعين للهجرة قضت السلطة على صاحب الزنج. قال العلاء بن صاعد بن مخلد: لما حمل رأس صاحب الزنج، ودخل به المعتضد إلى بغداد، دخل في جيش لم يرَ مثلُه، واشتق أسواق بغداد والرأس بين يديه. فلمّا صرنا بباب الطاق صاح قوم من درب من تلك الدروب: رحم الله معاوية، وزاد حتى علت أصوات العامّة بذلك، فتغيّر وجه المعتضد، وقال: ألا تسمع يا أبا عيسى؟! ما أعجب هذا! وما الذي اقتضى ذكر معاوية في هذا الوقت؟!
والله لقد بلغ أبي إلى الموت، وما أفلَتّ أنا إلّا بعد مشارفته، ولقينا كلّ جهد وبلاء حتى أنجينا هؤلاء الكلاب من عدوّهم، وحصّنّا حرمهم وأولادهم.
فتركوا أن يترحّموا على العباس وعبد الله ابنه ومن ولد من الخلفاء، وتركوا الترحّم على علي بن أبي طالب وحمزة وجعفر والحسن والحسين!
والله لا برحت أو أؤثر في تأديب هؤلاء أثراً لا يعاودون بعد هذا الفعل مثله. ثمّ أمر بجمع النفّاطين؛ ليحرق الناحية.
فقلت له: أيّها الأمير، أطال الله بقاءك، إنّ هذا اليوم من أشرف أيام الإسلام فلا تفسده بجهل عامّة لا خلاق لهم. ولم أزل أداريه وأرفق
به حتى سار(١) .
ويبدو أنّ ذلك بقي في نفس المعتضد رغم إغراق الجمهور في تقديس الصحابة الأوّلين ومَنْ سار على نهجهم في نظام الخلافة، نتيجة تأكيد السلطة العباسية وثقافتها العامّة عليه في مواجهة أهل البيت (صلوات الله عليهم) وشيعتهم، وخصوصاً معاوية الذي صار رمز العداء الظاهر لهم. وربما كان لإغراق الجمهور هذا بعض الأثر في إثارة حفيظة المعتضد.
فعزم في سنة مئتين وأربع وثمانين على لعن معاوية على المنابر، وأمر بإنشاء كتاب بذلك يقرأ على الناس، فخوّفه وزيره عبيد الله بن سليمان اضطراب العامّة، وأنّه لا يأمن أن تكون فتنة، فلم يلتفت إلى ذلك من قوله، وصمّم على ما عزم عليه.
وبدأ - في أواخر جمادى الأولى وأوائل جمادى الثانية من السنة المذكورة - بخطوات تمهيدية لمنع العامّة من التجمّع والشغب وإثارة المشاكل والفتن، وآخر تلك الخطوات منع السقّائين الذين يسقون الماء في الجامعين من الترحّم على معاوية وذكره بخير.
وتحدّث الناس أنّ الكتاب الذي أمر المعتضد بإنشائه بلعن معاوية يقرأ بعد صلاة الجمعة على المنبر. فلمّا صلّى الناس الجمعة بادروا إلى المقصورة ليسمعوا قراءة الكتاب فلم يُقرأ.
قال الطبري - بعد أن ذكر ذلك -: فذكر أنّ المعتضد أمر بإخراج الكتاب الذي كان المأمون أمر بإنشائه بلعن معاوية، فأُخرج له من الديوان، فأخذ من جوامعه نسخة هذا الكتاب، وذكر أنّها نسخة الكتاب الذي أُنشئ للمعتضد
____________________
١ - شرح نهج البلاغة ٨/٢١٢ - ٢١٣، واللفظ له، نثر الدرّ ٣/٩٥ - ٩٦ الباب الثالث، كلام الخلفاء من بني هاشم، المعتضد.
بالله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.... وذكر كتاباً طويلاً يقرب من سبع صفحات يتضمّن كثيراً من مثالب الأمويين، وخصوصاً معاوية، ممّا تضمّنته الأحاديث الشريفة والأحداث التاريخية.
ثمّ قال الطبري بعد أن أنهى الكتاب: وذكر أنّ عبيد الله بن سليمان أحضر يوسف بن يعقوب القاضي، وأمره أن يعمل الحيلة في إبطال ما عزم عليه المعتضد؛ فمضى يوسف بن يعقوب فكلّم المعتضد في ذلك، وقال له: يا أمير المؤمنين، إنّي أخاف أن تضطرب العامّة، ويكون منها عند سماعها هذا الكتاب حركة. فقال: إن تحرّكت العامّة أو نطقت وضعت سيفي فيها.
فقال: يا أمير المؤمنين، فما تصنع بالطالبيين الذين هم في كلّ ناحية يخرجون، ويميل إليهم كثير من الناس؛ لقرابتهم من الرسول ومآثرهم؟! وفي هذا الكتاب إطراؤهم، أو كما قال: وإذا سمع الناس هذا كانوا إليهم أميل، وكانوا في أبسط ألسنةٍ، وأثبت حجّة منهم اليوم؛ فأمسك المعتضد فلم يردّ عليه جواب، ولم يأمر في الكتاب بعده بشيء(١) .
وهكذا يكون الموقف السلبي من الطالبيين وأهل البيت (صلوات الله عليهم) حاجزاً دون بيان الحقائق، ومحفّزاً على تحريفها وتشويهها.
كما يتزامن تأكيد السلطة على احترام الأوّلين ومَنْ هو على خطّهم مع ارتفاع مستوى نصبها وعدائها لأهل البيت (صلوات الله عليهم)، بحيث تكون إحدى الظاهرتين قرينة للأخرى؛ ليتم بهما هدف واحد.
وبذلك تأكّد وتركّز ما بدأه الأوّلون، وزاد فيه معاوية من تفعيل احترام الخطّ المخالف لأهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسّلام)، ومن أهم أسبابه افتعال الأحاديث في تقديم الأوّلين، وفي فضائل الصحابة الذين هم على خطّهم.
____________________
١ - تاريخ الطبري ٨/١٨٢ - ١٩٠ في أحداث سنة ٢٨٤هـ.
وعلى كلّ حال صارت النصوص الكثيرة التي وضعت في عهد معاوية عاضدة لما وضع في العهد الأوّل، ومشيّدة لمضامينه وأهدافه.
وكانت نتيجة ذلك تدين الجمهور بشرعية خلافة الأوّلين، واحترام رموز الخطّ المخالف لأهل البيت (صلوات الله عليهم) احتراماً يبلغ حدّ التقديس.
وقد كان لذلك أعظم الأثر في مواجهة أهل البيت (صلوات الله عليهم)، والوقوف في وجه دعوتهم، كما توقّعه معاوية على ما يظهر من كلامه السابق.
وقد صار هذا التديّن والتقديس هما العقبة الكؤود أمام دعوى النصّ، تمنع الجمهور - نوعاً - من مصداقية الرؤية، ومن الموضوعية في البحث عن الحقيقة، ثمّ الوصول إليه.
بل صارت سبباً للتشنيع على شيعة أهل البيت تشنيعاً قد يصل حدّ التكفير، واستحلّت به دماؤهم، وانتهكت حرماتهم ومقدّساتهم على طول التاريخ وإلى يومنا هذا.
وكلّ ذلك بعين الله تعالى، وإليه يرجع الأمر كلّه.
ويأتي في المبحث الثاني إن شاء الله تعالى أثر فاجعة الطفّ في مواجهة هذا الاحترام والتقديس، واقتحام هذه العقبة.
قوّة خطّ الخلافة عند الجمهور يفضي إلى تحكيم السلطة في الدين
الجهة الثانية: إنّه بعد أن كان المفروغ عنه عند المسلمين على اختلاف توجّهاتهم - عدا الشاذ الذي لا يعتدّ به - واستفاضت به النصوص، هو لزوم الإمامة، فالصراع الظاهر لما كان منحصراً بين خطّ أهل البيت القاضي بإمامتهم، تبعاً للنصّ، والخطّ الآخر القاضي بعدم انضباط أمر الإمامة، وأنّ مَنْ تغلب فهو الإمام، فانحسار خطّ أهل البيت (عليهم السّلام) عقائدياً - نتيجة النصوص التي وضعت في
عهد معاوية وما سبقها ممّا ظهر في عهد الخلفاء الأوّلين - مستلزماً لقوّة الخطّ الثاني، وإضفاء الشرعية على إمامة المتغلّب وخلافته، بغضّ النظر عن شخصه وسلوكه.
ومن الطبيعي حينئذ أن يكون له التحكّم في الدين؛ جرياً على سنن الماضين واقتداءً بهم حيث يألف الناس ذلك، ويتأقلمون معه كأمر واقع. وقد تقدّم أنّ ذلك هو السبب في تحريف الأديان ومسخها.
وقد يقول قائل: إن احترام الجمهور للأولين، بل تقديسهم لهم هو الذي جعلهم يقبلون منهم ما شرّعوه من الأحكام، ولا يتعدى ذلك لغيرهم ممن تأخر عنهم، ولا يحظى بمثل ذلك الاحترام والتقديس.
لكنه يندفع: بأن قبول الجمهور لأحكام الأولين ليس من أجل احترامهم بأشخاصهم، بل من أجل منصبهم، حيث ابتنى المنصب في الصدر الأول على أن الخليفة هو المرجع للمسلمين في دينهم وفي إدارة أمور دنياهم. وذلك يجري فيمن بعدهم بعد فرض شرعية منصبهم.
ولذا جرى من بعدهم على سنتهم في كيفية اختيار الخليفة، وبقي العمل عليها مادامت الخلافة قائمة كأمر واقع، تبعاً لسنة الأولين بعد فرض شرعيتها عند الجمهور.
ولم تقتصر على الأولين لتميزهم بمزيد من الاحترام والتقديس بالرغم من اعتراف الشيخين نفسهما بأن بيعة أبي بكر كانت فلتة(١) ، وتحذير عمر من
____________________
(١) فقد روي ذلك عن الخليفة الأول في أنساب الأشراف ج: ٢ ص: ٢٧٤ أمر السقيفة، وكتاب العثمانية ص: ٢٣١، وسبل الهدي والرشاد ج: ١٢ ص: ٣١٥، وشرح نهج البلاغة ج: ٢ ص: ٥٠، ج: ٦ ص: ٤٧، وغيرها من المصادر.
وروي عن الخليفة الثاني في صحيح البخاري ج: ٨ ص: ٢٦ كتاب المحاريبين من أهل الكفر والردة: باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت، والسنن الكبرى للنسائي ج: ٤ ص: ٢٧٢ كتاب الرجم: تثبيت الرجم، ومسند أحمد ج: ١ ص: ٥٥ مسند عمر بن الخطاب: حديث السقيفة، وصحيح ابن حبان =
مثلها(١) وأمره بقتل من يعود إلى ذلك(٢) . إلا أن ذلك لما لم يسلب الشرعية عنها عندهم لم يمنعهم من الجرى على سننها.
وببيان آخر: كما يكون تمتع الأولين بمزيد من الاحترام والتقديس سبباً للتمسك بشرعية نظام الخلافة الذي جروا عليه، كذلك يكون سبباً لتحديد صلاحيات الخليفة، وحيث ابتنى المنصب عند الأولين على مرجعية الخليفة للمسلمين في الدين والدنيا معاً، يبقى ذلك مادام العمل على نظام تلك الخلافة قائماً، وكانت تلك الخلافة مشروعة عندهم، إلا أن تكون هناك محاولة للحد من اندفاع السلطة وفضحها.
أما التدهور في شخص الحاكم وسلوكه فعلى الإسلام والمسلمين قبوله كأمر واقع تقتضيه طبيعة الاستمرارية في المجتمعات التي يقودها غير المعصوم، من دون أن يخل بالشرعية لأصل الخلافة، ولا بصلاحيات الحاكم.
فهذا أبو بكر يقول في خطبته: «أما والله ما أنا بخيركم. ولقد كنت لمقامي هذا كارهاً. ولوددت أن فيكم من يكفيني. فتظنون أني أعمل فيكم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله! إذاً لا أقوم لها. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعصم بالوحي، وكان معه ملك. وإني لي شيطاناً يعتريني. فإذا غضبت فاجتنبوني، لا أوثر في أشعاركم ولا أبشاركم. ألا فراعوني، فإن استقمت فأعينوني، إن زغت فقوموني»(٣) .
____________________
= ج: ٢ ص: ١٤٨ كتاب البر والإحسان: باب حق الوالدين: ذكر الزجر عن أن يرغب المرء عن آبائه إذ استعمال ذلك ضرب من الكفر، وغيرها من المصادر الكثيرة جداً.
(١) تقدمت مصادره في الهامش السابق في ما روي عن الخليفة الثاني.
(٢) تاريخ اليعقوبي ج: ٢ ص: ١٥٨ أيام عمر بن الخطاب. شرح نهج البلاغة ج: ٢ ص: ٢٦، ٢٩، ٥٠، ج: ٦ ص: ٤٧، ج: ٢٠ ص: ٢١. المواقف ج: ٣ ص: ٦٠٠. وغيرها من المصادر.
(٣) المصنف لعبد الرزاق ج: ١١ ص: ٣٣٦ باب لا طاعة في معصية، واللفظ له. تخريج الأحاديث والآثار ج: ١ ص: ٤٨٢. المطالب العالية ج: ٩ ص: ٦٢٥ كتاب الخلافة والإمارة: باب كراهية أن يحكم الحاكم وهو غضبان. تاريخ دمشق ج: ٣٠ ص: ٣٠٤ في ترجمة أبي بكر الصديق. كنز العمال ج: ٥ ص: ٥٩٠ =
ويقول في خطبة له أخرى فيها: «... وإنكم اليوم على خلافة نبوة ومفرق محجة. وسترون بعدي ملكاً عضوضاً، وأمة شعاعاً، ودماً مفاحاً. فإن كانت للباطل نزوة، ولأهل الحق جولة يعفو لها الأثر، وتموت السنن. فالزموا المساجد، واستشيروا القرآن، والزموا الجماعة...»(١) .
وعمر يقول لابن عباس: «والله يا ابن عباس إن علياً ابن عمك لأحق الناس بها، ولكن قريشاً لا تحتمله. ولئن وليهم ليأخذنهم بمرّ الحق لا يجدون عنده رخصة...»(٢) . يشير بذلك إلى أنه لابد للحاكم أن يخرج عن الحق ويفسح لنفسه في الرخص بما يتناسب مع رغبة الناس وإرضائهم، جمعاً للكلمة.
وقدم معاوية المدينة فخطبهم، فقال: «إني رمت سيرة أبي بكر وعمر فلم أطقها، فسلكت طريقة لكم فيها حظ ونفع، على بعض الأثرة، فارضوا بما أتاكم مني وإن قلّ، فإن الخير إذا تتابع - وإن قلّ - أغنى، وإن السخطة يكدر المعيشة...»(٣) .
وخطب يزيد بن معاوية بعد وفاة أبيه، فقال: «إن معاوية كان حبلاً من حبال الله، مدّه ما شاء أن يمدّه، ثم قطعه حين شاء أن يقطعه. وكان دون من قبله، وهو خير ممن بعده... وقد وليت الأمر بعده، ولست أعتذر من جهل، ولا أشتغل بطلب علم. وعلى رسلكم، إذا كره الله أمراً غيّره»(٤) ... إلى غير ذلك.
____________________
= ح: ١٤٠٥٠، ص: ٦٣٦ ح: ١٤١١٨. وغيرها من المصادر الكثيرة.
(١) تقدمت مصادرها في ص: ١٨٩.
(٢) تاريخ اليعقوبي ج: ٢ ص: ١٥٩ أيام عمر بن الخطاب.
(٣) أنساب الأشراف ج: ٥ ص: ٥٥ في ترجمة معاوية بن أبي سفيان.
(٤) عيون الأخبار ج: ٢ ص: ٢٣٨ - ٢٣٩ كتاب العلم والبيان: الخطب، واللفظ له. العقد الفريد ج: ٤ ص: ٨٨ فرش كتاب الخطب، ص: ٣٤٣ فرش كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم: وفاة معاوية. مروج الذهب ج: ٣ ص: ٧٦ ذكر لمع من أخبار يزيد وسيره ونوادر من بعض أفعاله. جمهرة خطب العرب ج: ٢ ص: ١٧٨ خطب الأمويين: خطب يزيد بن معاوية. وغيرها من المصادر.
وكما لم يؤثر ذلك على شرعية السلطة والخلافة لا يؤثر في تحديد صلاحيات الخليفة، بل يبقى هو المرجع للمسلمين في دينهم، كما كان الأولون.
ولا سيما أن السلطة يتيسر لها اختلاق النصوص النبوية المؤكدة لسيرة الأولين في مرجعية الخليفة في الدين، بالتعاون مع علماء السوء ورجال الحديث الذين ينسقون معها ويعيشون على مائدتها، كما سبق نظيرة في وجوب الطاعة ولزوم الجماعة، وكما حصل في بعض الأديان السابقة.
أضف إلى ذلك أن ظهور التدهور والتسافل في شخص الحاكم وسلوكه للجمهور وإيمانهم به إنما كان بجهود المعارضة وتنبيهها وإنكارها باستمرار، فإذا كسبت السلطة الشرعية بمبايعة الإمام الحسين (صلوات الله عليه) وغيره من النخب، وبدأت في خنق صوت المعارضة وملاحقتها وتحجيم دورها، تيسر لها - بما تملك من قوى إعلامية وتثقيفية هائلة، وبالاستعانة بعلماء السوء والنتهازيين - كسب تقديس الجمهور وإغفاله عن جرائمها وتسافلها، كما حصل في الشام نتيجة غياب المعارضة. بل حتى في إفريقية، كما تقدمت بعض شواهد ذلك عند الكلام في تركيز السلطة على وجوب الطاعةلإ وفي ظهور حجم الخطر بملاحظة مواقف الأمويين وتشويههم للحقائق(١) .
وبذلك تعرّض دين الإسلام العظيم للخطر القاتل. بل تعرّضت الحقيقة الدينية المقدّسة عموماً للتشويه والضياع الأبدي، إذ الإسلام خاتم الأديان، وليس بعده دين ولا وحي يظهر الحقيقة، ويدافع عنها. ويأتي في أوائل المقام الثالث إن شاء الله تعالى ما ينفع في المقام.
تفاقم الخطر بتحويل الخلافة إلى قيصرية أموية
ويزيد في هذا الخطر أنّ معاوية قد عهد بالخلافة إلى ولده يزيد حيث تحولّت إلى هرقلية قيصرية في ضمن عائلة خاصة؛ إذ تستخدم هذه العائلة الدين حينئذ لخدمة أهدافها ذات الأمد الطويل.
ولاسيما بعد أن كانت تلك العائلة خصماً عنيداً للإسلام؛ لما هو المعلوم من موقفهم المناهض له في بدء ظهور دعوته، وقد وترهم الإسلام في أنفسهم، وفي موقعهم الاجتماعي.
مضافاً إلى ظهور استهتارهم بالمبادئ والقيم بحيث لا يقفون عند حدّ، ولا يمنعهم من تحقيق أهدافهم شيء.
وقد سبق منّا عرض بعض مواقفهم وثقافتهم التي كانوا يثقّفون بها أهل الشام، ويحاولون تعميمها في المسلمين وحملهم عليها عند التعرّض لما يتوقّع أن يترتّب على الانحراف الذي حصل؛ نتيجة الخروج بالسلطة في الإسلام عن واقعها الذي أراده الله تعالى، وقامت الأدلّة والنصوص عليه.
حديث المغيرة بن شعبة عن خطر البيعة ليزيد
وكأنّ المغيرة بن شعبة قد أدرك ذلك؛ فقد بلغه أنّ معاوية يريد عزله عن ولاية الكوفة فأراد أن يستميله؛ كي يبقيه في ولايته ولا يعزله؛ فأشار عليه بولاية العهد ليزيد، فقال له معاوية: ومَنْ لي بهذا؟ فقال: أُكفيك أهل الكوفة، ويكفيك زياد أهل البصرة. وليس بعد هذين المصرين أحد يخالفك. فقال له معاوية: فارجع إلى عملك، وتحدّث مع مَنْ تثق إليه في ذلك وترى ونرى.
فودّعه ورجع إلى أصحابه، فقال: لقد وضعت رجل معاوية في غرز
بعيد الغاية [الغي] على أُمّة محمد، وفتقت عليهم فتقاً لا يرتق أبداً(١) .
وإنّ النظرة الموضوعية للواقع الذي حصل بتفاصيله وتداعياته تشهد بصحة هذا التقييم لبيعة يزيد، وللنتائج المتوقّعة عليه.
ما حصل هو النتيجة الطبيعية لخروج السلطة عن موضعها
ومهما يعتصر قلب المسلم ألماً لذلك، فإنّه لا ينبغي أن يستغرب ما حصل؛ إذ هو النتيجة الطبيعية للخروج عن مقتضى النصّ الإلهي؛ إذ كلّما امتدّ الزمن بالانحراف في المسيرة، وفتح الباب للاجتهادات والمبرّرات لمواقف السلطة، وألف الناس ذلك، تضاعفت التداعيات والسلبيات، وزاد السير بعداً عن الطريق المستقيم، وفقدت القيود والضوابط بنحو يتعذّر معه الرجوع إليه، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.
ولنكتف بهذا المقدار في عرض مواقف السلطة في عهد معاوية لمواجهة جهود أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسّلام) في كبح جماح الانحراف الذي حصل؛ نتيجة الخروج بالسلطة في الإسلام عن موضعه، وخروج الأُمّة في مسيرتها عن الطريق الصحيح الذي أراده الله تعالى له.
____________________
١ - الكامل في التاريخ ٣/٥٠٤ أحداث سنة ست وخمسين من الهجرة، ذكر البيعة ليزيد بولاية العهد، واللفظ له، النصائح الكافية/٦٤، وقريب منه في سير أعلام النبلاء ٤/٣٩ في ترجمة يزيد بن معاوية، وتاريخ الإسلام ٥/٢٧٢ في ترجمة يزيد بن معاوية، وتاريخ دمشق ٣٠/٢٨٧ في ترجمة أبي بكر الصديق، وج ٦٥/٤١٠ في ترجمة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، وتاريخ اليعقوبي ٢/٢٢٠ أيام معاوية بن أبي سفيان، وغيرها من المصادر.
المقام الثالث
في أثر فاجعة الطفّ في الإسلام بكيانه العام
مات معاوية وقد خلّف للإسلام تركة ثقيلة؛ حيث أقام دولة ذات أهداف قبلية جاهلية، تتخذ من الإسلام ذريعة لتحقيق أهدافه، ولو بتحريفه عن حقيقته كما سبق.
ولو قدّر لها البقاء والعمل كما تريد لقضت على جهود أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في كبح جماح الانحراف، وتعريف المسلمين بمعالم دينهم؛ ليستضيء بها مَنْ يطلب الدين الحقّ، ويحاول التعرّف عليه والتمسّك به.
أحكم معاوية بناء دولة قوية
وقد أحكم معاوية بناء هذه الدولة وأرسى أركانها بالترغيب والترهيب، والإعلام الكاذب والتثقيف المنحرف، وإثارة العصبية والنعرات الجاهلية، فكانت هي المعايير العامّة في إعلان الولاء والتأييد.
وتجاهل ذوو النفوذ في المجتمع ما عداها من دواعي الدين والمبادئ والمثل والأخلاق، وتسابقوا في إرضاء السلطة والتزلّف لها والتعاون معها ودعمها، وأَلِفَ الجمهور ذلك وتأقلموا معها؛ على أنّه هو الواقع العملي للخلافة والسلطة، وللدين الذي تمثله.
وقد أوضح ذلك معاوية في وصيته لابنه يزيد، حيث قال له في مرضه
الذي توفي فيه: يا بني، إنّي قد كفيتك الرحلة والترحال، ووطأت لك الأشياء، وذلّلت لك الأعداء، وأخضعت لك أعناق العرب، وجمعت لك من جمع واحد. وإنّي لا أتخوّف أن ينازعك هذا الأمر الذي استتبّ لك إلّا أربعة نفر...(١) .
امتعاض ذوي الدين من انحراف السلطة عن تعاليمه
وبقي هناك ثلّة من المسلمين من ذوي الدين والمثل، أو ممّن يتظاهرون بذلك، ينظرون لما يجري على مضض، وعمدة ما يشغل بالهم ويقلقهم، أو يظهرون القلق من أجله، هو انحراف السلطة، وخروجها عن تعاليم الدين، وظلمها وطغيانها، واستئثارها، وما يجري مجرى ذلك.
أمّا مسألة تحريف الدين وضياع معالمه فلا يظهر منهم التوجّه له والاهتمام بأمره والحديث حوله، فضلاً عن العمل لمنعه.
ونتيجة لذلك ينحصر الإصلاح بنظرهم بتغيير السلطة، وجعل الخلافة في موضعها المناسب لها، كسلطة دينية ترعى الدين وتعاليمه، ويهمّها أمر المسلمين وصلاح أمرهم.
وقد يرشّح لذلك، أو يتصدّى للمطالبة بها جماعة. وعلى رأسهم الإمام الحسين (صلوات الله عليه) الذي هو الرجل الأوّل في المسلمين ديناً ومقاماً وقرابة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أوضحناه عند الكلام في أبعاد فاجعة الطفّ.
وهؤلاء النفر القليل على قسمين:
____________________
١ - تاريخ الطبري ٤/٢٣٨ أحداث سنة ستين من الهجرة، واللفظ له، البداية والنهاية ٨/١٢٣ أحداث سنة ستين من الهجرة، تاريخ ابن خلدون ٣/١٨ وفاة معاوية، الفتوح لابن أعثم ٤/٣٥٤ ذكر الكتاب والعهد إلى يزيد، وغيرها من المصادر.
مَنْ يرى إمكان إصلاح السلطة وتعديل مسارها
الأوّل : مَنْ يرى التفكير في ذلك عملياً، ويحاول السعي له؛ إمّا بمكر ودهاء؛ أملاً في المكاسب المادية، والوصول لمراكز النفوذ وصنع القرار بعد التغيير، وإمّا بحسن نيّة؛ نتيجة الموقف الانفعالي من الفساد الذي حصل، وبتخيّل وجود الآلية الكافية للصراع مع الوضع القائم.
ومن الصنف الثاني خواصّ الشيعة في الكوفة الذين كانوا يستثيرون الإمام الحسين (عليه السّلام) بعد موت الإمام الحسن (عليه السّلام)، كما استثاروا الإمام الحسن (صلوات الله عليه) من قبل وكانوا يرون أنّ في موت معاوية فرصة لا ينبغي تضييعها.
مَنْ يرى تجنّب الاحتكاك بالسلطة حفاظاً على الموجود
الثاني: مَنْ يرى أنّ التفكير في ذلك غير عملي، وأنّ الموازنة بين القوى لا تسمح بها بعد ما انتهى إليه وضع المسلمين بعد انحراف مسار السلطة وما ترتّب عليه من مضاعفات، وآخرها سياسة معاوية السابقة.
ولاسيما أنّ الفشل العسكري الذي مُنيت به تجربة الإصلاح، وتعديل مسيرة السلطة في الإسلام التي قادها أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) أوجب الإحباط عند الخاصة الذين من شأنهم الموازنة بين القوى وعدم الاندفاع العاطفي في اتخاذ المواقف.
حيث لا يتوقّع أن يأتي قائد أفضل من أمير المؤمنين (عليه السّلام) علماً بالدين، وإخلاصاً لقضيته، والتزاماً بالمبادئ، وشجاعة وصلابة في الموقف، وسابقة وأثراً في الإسلام، ولا أظهر شرعية منه عند الكلّ بعد تمامية بيعته باختيار عامّة المسلمين.
حتى إنّه لا إشكال عند أهل العلم والمعرفة أخيراً في شرعية خلافته، وبغي الخارجين عليه، ووجوب قتالهم، كما ذكرنا بعض ما يتعلّق بذلك في أواخر الكلام في المقام الأوّل(١) .
كما لا يتهيأ أنصار أكثر من أنصاره ولا أفضل؛ حيث بايعه عن قناعة تامّة الكثرة الكاثرة من المسلمين، وفيهم العدد الكثير من المهاجرين والأنصار وذوي السابقة والأثر الحميد في الإسلام، ومن أهل النجدة في العرب، وذوي المقام الاجتماعي والنفوذ فيهم، والذين لهم الأثر الكبير في فتوح الإسلام، وقد قدّموا من أجل دعمه (عليه السّلام) ونجاح مشروعه أعظم التضحيات.
وأيضاً لا يتوقّع - بمقتضى الوضع الطبيعي - أن يأتي زمان أفضل من زمانه (عليه السّلام)؛ لقربه من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتعرّف على تعاليمه، ووجود الكثرة الكاثرة من صحابته.
وقد أكّدت الأحداث المتلاحقة ذلك حيث لم يسجّل تاريخ الإسلام نجاح حركة إصلاحية حقيقية - تلتزم المبادئ في أهدافه، وفي وسائل نجاحها في صراعاته؛ محافظة على نقائها واستقامتها - وبقاءها مدّة أطول من عهد أمير المؤمنين (صلوات الله عليه).
ويعلم أهل المعرفة أنّ انهيار مشروعه (صلوات الله عليه) عسكرياً إنّما تسبّب عن التزامه بالمبادئ وحرفية التشريع، واستغلال خصومه ذلك ومحاولتهم الخروج عنه، والالتفاف عليه في وسائل صراعهم معه، وفي تثبيت سلطانهم بعده؛ لوجود الأرضية الصالحة لتقبّل ذلك من عامّة الناس؛ لعدم استحكام الدين والمبادئ في نفوسهم، وثقل الأمانة والاستقامة عليهم.
ولا يتوقّع صلاح المجتمع الإسلامي بعد أن دخله الفساد، بل كلّما زادت
____________________
١ - راجع/٢٧٥ وما بعده.
ألفتهم له زاد استحكامه فيهم، وتعذّر تطهيرهم منه.
نعم، يمكن أن يغلب الباطل بباطل مثله في المكر، وانتهاك الحرمات، والخروج عن المبادئ والقيم والالتفاف عليه كما حصل. والدنيا دول.
ونتيجة لذلك كان توجّه هؤلاء النفر إلى المحافظة على الموجودين من ذوي الدين والصلاح بتجنّب الاحتكاك بالحاكم؛ لأنّ ذلك غاية الميسور.
وربما يكون ذلك هو المنظور لكثير ممّن أشار على الإمام الحسين (صلوات الله عليه) بترك الخروج على يزيد، ومنهم عبد الله بن جعفر كما يظهر من كتابه للإمام الحسين (عليه السّلام) الذي تقدّم التعرّض له في المطلب الأوّل(١) .
بل كلّما زاد الاحتكاك بالحاكم، وتحقّق منه التجاوز عن الحدّ في الردّ زاد جرأة على انتهاك الحرمات، وأبعد في التجاوز عليه، وتعوّد الناس على ذلك وألفوه، وخفّ استنكارهم له.
فكيف إذا كان المنتهك حرمته هو الإمام الحسين (عليه أفضل الصلاة والسّلام) الذي هو أعظم الناس حرمة، والرجل الأوّل في المسلمين؟! كما يشير إلى ذلك ما تقدّم منه (صلوات الله عليه) في المعركة، ومن عبد الله بن مطيع في حديثه معه (عليه السّلام)(٢) وغير ذلك.
وربما تُدعم وجهة نظر هؤلاء بأمرين:
الأوّل: الحذر من شقّ كلمة المسلمين وتفريق جماعتهم، وإلقاح الفتنة بينهم الذي قد يتشبّث به الكثير جهلاً، أو نفاقاً وممالأة للظالم.
الثاني: طلب العافية جبناً، أو لعدم الشعور بالمسؤولية.
____________________
١ - تقدّم في/٦٣.
٢ - راجع/٦٣.
موقف أهل البيت (عليهم السّلام) إزاء المشكلة
لكنّ أهل البيت (صلوات الله عليهم) على بصيرة تامّة من أنّ تعديل مسار السلطة في الإسلام بعد انحرافها من اليوم الأوّل أمر متعذّر في الأمد المنظور. ويأتي توضيح ذلك - إن شاء الله تعالى - في المقام الثاني من الفصل الثاني في العبر التي تستخلص من فاجعة الطفّ.
وقد سبق أنّ أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسّلام) كان على علم بما يؤول إليه أمر بيعته من الفشل العسكري، وأنّ ما ظهر لنا من ثمرات قبوله بالخلافة هو إظهار الحقيقة، وإيضاح معالم الدين، وتشييد دعوة الحقّ، وإيجاد جماعة صالحة تقتنع بتلك الدعوة وتحمّلها وتدعو لها، وترفض دعوة الباطل وتشجب شرعيتها وشرعية السلطة التي تتبنّاه، وتنكر عليها الجرائم والمنكرات التي تقوم بها، وتحاول فضحها، وقد حقّق ذلك بنجاح.
بيعة يزيد تعرض جهود أمير المؤمنين (عليه السّلام) للخطر
غير أنّ جهوده (صلوات الله عليه) أصبحت مهدّدة بالخطر؛ نتيجة خطوات معاوية المتلاحقة، وآخرها البيعة لابنه يزيد في دولة قوية قد أرسى قواعده، وأحكم بنيانه، وأُمّة متخاذلة أنساها دينها ومثلها، وأحيى دعوة الجاهلية فيها، وسلبها شخصيتها وكرامتها، وأذلّها بالترغيب والترهيب، وشوّه مفاهيمها وتعاليمها بالإعلام الكاذب والتثقيف المنحرف.
ومن الظاهر أنّ البيعة ليزيد كانت تدهوراً سريعاً في معيار اختيار الخليفة، وابتداعاً لأمر لم يعهده المسلمون من قبل، ولم يألفوه بعد ولا تقبّلوه.
أوّلاً: بلحاظ واقع يزيد التافه، وسلوكه الشخصي المشين، وظهور استهتاره بالدين والقيم، ومقارفته للموبقات، وانغماسه في الشهوات.
وثانياً : بلحاظ ابتناء اختياره على وراثة الخلافة وانحصارها بآل معاوية، وتجاهل أكابر المسلمين من بقايا الصحابة وأبنائهم، ولاسيما بعد ما عاناه الإسلام والمسلمون من حكم معاوية نفسه، وتجربته المرّة التي مرّت بهم.
فإذا لم يستغل ذلك في الإنكار والدعوة للتغيير، وبقيت الأمور على ما هي عليه، وبايع أكابر المسلمين - وعلى رأسهم الإمام الحسين (صلوات الله عليه) - يزيد، تأكّدت شرعية تلك الدولة القوية التي ينتظر منها القضاء على الدين وعلى جهود أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في كبح جماح الانحراف.
عدم تبلور مفهوم التقيّة
وخصوصاً أنّ مفهوم التقيّة لم يتبلور بعد عند عامّة المسلمين، ولا يدركون أنّ الاستجابة للبيعة والسكوت عن إنكار المنكر؛ نتيجة القسر والضغوط القاهرة لا يضفي شرعية على الوضع القائم.
ولاسيما بعد تصدّي مثل حجر بن عدي الكندي وجماعته وغيرهم من وجوه الشيعة وأعيان المسلمين للإنكار، ودفعهم الثمن الغالي في سبيله، وعدم أخذهم بالتقيّة في السكوت عن الباطل(١) .
والإمام الحسين (صلوات الله عليه) أعرف منهم بالوظيفة الشرعية، وأحرى برعاية الدين، وأقوى منهم - بنظر عامّة الناس - بما يملكه من مركز ديني واجتماعي رفيع. فبيعته (عليه السّلام) ليزيد تضفي الشرعية على السلطة بنظر جمهور
____________________
١ - لعلّ إصرار هؤلاء على موقفهم، وعدم أخذهم بالتقيّة؛ لعدم تركّز المفاهيم الحقة التي كانوا يتبنّوه، فأخذهم بالتقيّة يوجب ضياع الحقّ على الناس، وهو أشدّ محذوراً من تضحيتهم بأنفسهم، نظير موقف الإمام الحسين (صلوات الله عليه) في وقته، ولاسيما مع قرب أن تكون مواقفهم هذه قد كانت بعهد معهود من أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسّلام)، كما يستفاد ذلك في الجملة من كثير من النصوص، وللكلام مقام آخر.
المسلمين، ولا تحمل على التقيّة.
ويناسب ما ذكرنا - من عدم تبلور مفهوم التقيّة - أنّ بسر بن أرطاة لما أغار على المدينة المنوّرة في أواخر عهد أمير المؤمنين (عليه السّلام) وأخذ أهلها بالبيعة لمعاوية. قال لبني سلمة: والله ما لكم عندي أمان حتى تأتوني بجابر بن عبد الله. فانطلق جابر إلى أُمّ سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها: ماذا ترين؟ إنّ هذه بيعة ضلالة، وقد خشيت أن أُقتل. قالت: أرى أن تُبايع؛ فإنّي قد أمرت ابني عمر وختني ابن زمعة أن يبايع.... فأتاه جابر فبايعه(١) .
وكذا ما ذكره المؤرّخون من البيعة التي طلبها مسلم بن عقبة من أهل المدينة بعد واقعة الحرّة. قال اليعقوبي: ثمّ أخذ الناس على أن يبايعوا على أنّهم عبيد يزيد بن معاوية، فكان الرجل من قريش يؤتى به فيُقال: بايع على أنّك عبد قن ليزيد. فيقول: لا. فيُضرب عنقه. فأتاه علي بن الحسين (عليه السّلام) فقال: «علامَ يريد يزيد أن أبايعك؟». قال: على أنّك أخ وابن عم. فقال: «وإن أردت أن أبايعك على إنّي عبد قن فعلت». فقال: ما أُجشمك هذا. فلمّا أن رأى الناس إجابة علي بن الحسين (عليه السّلام) قالوا: هذا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بايعه على ما يريد، فبايعوه على ما أراد(٢) .
وقد منع (صلوات الله عليه) بذلك عملية القتل والإبادة الجماعية التي
____________________
١ - الكامل في التاريخ ٣/٣٨٣ أحداث سنة أربعين من الهجرة، ذكر سرية بسر بن أبي أرطأة إلى الحجاز واليمن، تاريخ الطبري ٤/١٠٦ في أحداث سنة أربعين من الهجرة، الاستيعاب ١/١٦٢ في ترجمة بسر بن أرطأة، البداية والنهاية ٧/٣٥٦ أحداث سنة أربعين من الهجرة، شرح نهج البلاغة ٢/١٠، ونحوه في كتاب الثقات ٢/٣٠٠، وتاريخ دمشق ١٠/١٥٢ - ١٥٣ بسر بن أبي أرطأة، وتهذيب الكمال ٤/٦٥ في ترجمة بسر بن أرطأة، وغيرها من المصادر الكثيرة.
٢ - تاريخ اليعقوبي ٢/٢٥٠ - ٢٥١ مقتل الحسين بن علي.
تعرّضت لها الأُمّة المنكوبة، ونبّه لتشريع الله (عزّ وجلّ) التقيّة من أجل الحفاظ على المسلمين المضطهدين، وذلك بعد أن اتّضحت معالم الحقّ، وفقدت السلطة شرعيتها بسبب فاجعة الطفّ ومضاعفاتها.
لم يخرج على سلطة الأمويين إلّا الخوارج الذين سقط اعتبارهم
ويزيد في تعقد الأمور أنّه لم يعرف عن أحد قبل الإمام الحسين (عليه السّلام) الخروج على الحكم الأموي - مع شدّة مخالفته للدين، وطول مدّته - إلّا الخوارج الذين قد سقط اعتبارهم عند المسلمين.
أوّلاً : لظهور بطلان أُسس دعوتهم، خصوصاً بعد قتال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) لهم، وفتكه بهم في بدء ظهورهم، مع ما تظافر عنه (عليه السّلام) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبله من الطعن فيهم، والحكم بهلاكهم.
وثانياً : لتطرّفهم وانتهاكهم للحرمات بنحو أوجب مقت عامّة المسلمين لهم. وقد استغلت السلطة ذلك كلّه ضدّهم، وضدّ كلّ مَنْ يخرج عليه حتى الإمام الحسين (صلوات الله عليه) حيث حاولت في عنفوان اصطدامها به أن تجعله ومَنْ معه خوارج مهدوري الدم شرعاً، كما تقدّمت بعض شواهد ذلك عند الكلام على تركيز السلطة على وجوب الطاعة ولزوم الجماعة.
ومن الطريف في ذلك ما ورد من أنّ هاني بن عروة لما ذهب إلى ابن زياد زائراً، وطلب منه ابن زياد أن يدفع إليه مسلم بن عقيل (عليه السّلام)، وامتنع من ذلك معتذراً بأنّه ضيفه وجاره، طلب ابن زياد أن يدنوه منه، فلمّا أدنوه استعرض وجهه بالقضيب فلم يزل يضرب أنفه وجبينه وخدّه حتى كسر أنفه ونثر لحم خدّيه وجبينه على لحيته، وسالت الدماء على ثيابه حتى كُسر القضيب. فلمّا ضاق الأمر بهاني ضرب يده إلى قائم سيف شرطي ليدافع عن نفسه فجاذبه الشرطي
ومنعه، فقال ابن زياد لهاني: أحروري سائر اليوم؟! أحللت بنفسك قد حلّ لنا قتلك(١) .
فكأنّ المفروض على هاني أن يستسلم لابن زياد ويتركه يفعل به ما يشاء، ولا يدافع عن نفسه وإلاّ كان حرورياً خارجياً يهدر دمه ويحلّ قتله!
والحاصل: أنّه لا أثر لخروج الخوارج على السلطة في سلب شرعيته، والحدّ من غلوائه بعد إقرار أكابر المسلمين له، ودخولهم في طاعته.
موقف الشيعة من الأوّلين يحول دون تفاعل الجمهور معهم
كما أنّه لم يحمل لواء الإنكار على الأمويين وعلى تحريفهم للدين - بعد الخوارج - إلّا الشيعة، وهم وإن كانوا قد فرضوا احترامهم بأشخاصهم على المسلمين؛ لما عرفوا به من التقوى والعلم وصدق اللهجة حتى أخذ الجمهور بروايات محدّثيهم في الصدر الأوّل مع علمهم بتشيّعهم ومخالفتهم لهم(٢) . وروي عن سفيان الثوري قوله: هل أدركت خيار الناس إلّا الشيعة؟(٣) .
وفي صحيح زيد الشحّام عن الإمام الصادق (صلوات الله عليه) في وصيته لشيعته: «أوصيكم بتقوى الله (عزّ وجلّ)، والورع في دينكم، والاجتهاد لله، وصدق الحديث، وأداء الأمانة...، فوالله لحدّثني أبي (عليه السّلام) أنّ الرجل كان يكون
____________________
١ - تاريخ الطبري ٤/٢٧٣ - ٢٧٤ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين (عليه السّلام)...، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/٢٩ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين بن علي (عليه السّلام)...، البداية والنهاية ٨/١٦٦ أحداث سنة ستين من الهجرة، قصة الحسين بن علي وسبب خروجه من مكة في طلب الإمارة ومقتله، نهاية الأرب في فنون الأدب ٢٠/٢٤٧ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر استعمال عبيد الله بن زياد على الكوفة وقدومه إليها وخبره مع هانئ بن عروة، وغيرها من المصادر.
٢ - راجع كتاب المراجعات/١٠٤ - ١٩٤ المراجعة ١٦.
٣ - مقاتل الطالبيين/١٩٥ من خرج مع محمد بن عبد الله من أهل العلم.
في القبيلة من شيعة علي (عليه السّلام) فيكون زينها آداهم للأمانة، وأقضاهم للحقوق، وأصدقهم للحديث. إليه وصاياهم وودائعهم. تسأل العشيرة عنه فتقول: مَنْ مثل فلان؟! أنّه لآدانا للأمانة، وأصدقنا للحديث»(١) ... إلى غير ذلك.
إلاّ أنّ من المعلوم أنّ الشيعة قد تعرّضوا لشتى صروف التنكيل المشار إليها آنفاً فلا يسهل إيصال إنكارهم للجمهور وتعميم دعوتهم.
مع إنّهم يصطدمون مبدئياً بشرعية خلافة الأوّلين، ويتبنّون نقد مواقفهم ومواقف مَنْ كان على خطّهم مع ما لبعض أولئك من مكانة في نفوس جمهور المسلمين قد تبلغ حدّ التقديس.
وذلك يكون حاجزاً دون السماع من الشيعة والتفاعل بحديثهم، خصوصاً إذا بايع إمامهم الحسين (صلوات الله عليه) وغيره من ذوي المكانة في المجتمع الإسلامي.
التفاف السلطة على الخاصة لإضعاف تأثيرهم على الجمهور
كما إنّ الخاصة من ذوي الدين والمقام الرفيع في المسلمين إذا انسجموا مع الحاكم الظالم خَفَتَ بريقهم، وسقطت هالة الاحترام والتقديس لهم؛ فيضعف تأثيرهم تدريجاً في إصلاح المجتمع الإسلامي، وتنبيهه من غفلته.
ولاسيما إنّ الحاكم - من أجل تثبيت شرعية حكمه - يحاول جرّهم؛ للانصهار به، وجعلهم واجهة له يتجمّل بهم، أو يجعلهم آلة لقضاء مآربه.
فإنّ امتنعوا حجّم دورهم، أو قضى عليهم. وإن تجاوبوا معه لوّثهم بجرائمه، فيقل احترام في نفوس الناس تدريجاً، ويضعف تأثيرهم في إصلاح
____________________
١ - الكافي ٢/٦٣٦ باب ما يجب من المعاشرة ح ٥، وسائل الشيعة ٨/٣٩٨ - ٣٩٩ باب ١ من أبواب أحكام العشرة ح ٢.
المجتمع، حتى ينتهي أخيراً وينفرّد هو في الساحة.
شرعية السلطة تيسّر لها التدرّج في تحريف الدين
وإذا مضت مدّة معتدٍ بها، وتحقّق للسلطة ما تريد، تعامل الناس معها على أنّها الأمر الواقع الممثّل للدين، والمفروض من قِبّل الله عز وجل.
وحينئذ يتيسّر لها التلاعب به وفق أهدافها وأهوائها، وانطمست معالم الدين الحقّ، وكان الدين عندهم دين السلطة، أو المؤسسة التي تنسّق معها.
وحتى لو فرض تبدّل السلطة نتيجة العوامل الخارجية، فإنّ السلطات المتعاقبة تبقى هي المرجع في الدين - جرياً على سنن الماضين - بعد أن انطمست معالمه، وضاعت الضوابط فيه، وهكذا يبقى الدين أداة بيد السلطة تستغلّه لصالحه، كما حصل ذلك في الأديان السابقة.
وببيان آخر: إنّ تعديل مسار السلطة وإن كان متعذّراً، إلّا إنّ السكوت عن سلطة الباطل في ذلك المنعطف التاريخي له، والتعامل معها على أساس الاكتفاء بالميسور من التخفيف في الجريمة والمخالفة للدين والتحريف فيه، يفسح لها المجال للتدرّج في تحقيق أهدافها في تحريف الدين، وتحويره بنحو يكون أداة لتركيز نفوذها وتثبيت شرعيتها، وإكمال مشروعها.
وذلك يكون بأمرين:
الأوّل : التدرّج في المخالفات والتحريف بنحو لا يستفزّ الجمهور، وكلّما ألف الجمهور مرتبة من الانحراف انتقلت للمرتبة الأعلى، وهكذا حتى يألف الجمهور تحكّم السلطة في الدين وتحويرها له.
الثاني : التدرج في إضعاف المعارضة مادياً بالتنكيل بها، ومعنوياً بجرها للانصهار بالسلطة، إلى أن تنتهي فاعليتها وقدرتها على تحريك الجمهور
وتثقيفهم على خلاف ثقافة السلطة.
ونتيجة لذلك يُستغفل الجمهور، ويألف مرجعية الدولة في الدين، وأخذه منه، وتأخذ الدولة حريتها فيما تريد، وتتمّ لها أهدافها.
وهناك محذوران آخران يترتبان على ذلك لا يقلان أهمّية عنه:
تبعية الدين للسلطة تخفف وقعه في نفوسهم
الأوّل : إنّ الناس إذا ألفت الدين الذي تأخذه من الدولة، وتعارفت عليه، ونسي الدين الحقّ، خفّ وقع الدين في نفوسهم، وضعفت حيويته وفاعليته، وبقي طقوساً وشعارات فارغة، وهو ما سعى إليه معاوية من تحكيم الترهيب والترغيب، وإثارة النعرات الجاهلية، وعزل المبادئ والمثل على ما سبق.
بل يتلوّث الدين على الأمد البعيد بجرائم السلطة، وتتشوّه صورته تبعاً له؛ فتتنكّر الناس له لشعورهم بأنّه جاء ليدعم الدولة، ويكون آلة بيدها تنفّذ عن طريقه مشاريعها الظالمة وأهدافها العدوانية، وحينئذ تبدأ الناس بالتحلل منه والخروج عنه تدريجاً، كما حصل في الأديان السابقة.
ومن المعلوم أنّ من أهم أسباب الموقف السلبي - الذي اتخذه الغرب الرأسمالي والشيوعية الشرقية في العصور القريبة - من الدين هو ردّ الفعل لاستغلال السلطة للدين في العصور المظلمة، وتنسيقها مع مؤسساته لخدمة أهدافها، واستعبادها للشعوب.
قد ينتهي التحريف بتحول الدين إلى أساطير وخرافات
الثاني : إنّ التحريف كثيراً ما ينتهي بالدين إلى أساطير وخرافات وتناقضات تتنافى مع الفطرة، ولا يتقبّلها العقل السليم؛ فإمّا أن يرفضه ذوو
المعرفة والعقول المتفتحة جملة وتفصيلاً، أو يكتفوا في اعتناقه بمحض الانتساب تأثراً بالبيئة، أو مع التبني تعصّباً وتثبيتاً لهويتهم التي توارثوها عن آبائهم من دون أن يأخذ موقعه المناسب من نفوسهم.
ويتّضح ذلك بالنظرة الفاحصة للتراث الذي ينسب للأديان السماوية السابقة على الإسلام، وتتبنّاه حتى الآن المؤسسات الدينية الناطقة باسمها.
وهكذا الحال في كثير من التراث الإسلامي المشوّه الذي كان لانحراف السلطة الأثر في إقحامه في تراث الإسلام الرفيع.
وقد استغلّه أعداء الإسلام - من المستشرقين وأمثالهم - للنيل من الإسلام والتهريج عليه، وهم يجهلون أو يتجاهلون براءة الإسلام منه، وأنّه دخيل فيه مكذوب عليه.
بل من القريب أن تكون كثير من الأديان الباطلة الوثنية وغيرها ترجع في أصولها إلى أديان سماوية حقّة قد مسختها يد التحريف والتشويه حتى أخرجتها عن حقيقتها، وإن بقيت تحمل بعض ملامحه، أو شيئاً من تعاليمها.
ويتّضح ذلك في العرب قبل الإسلام حيث بقيت فيهم كثير من ملامح دين إبراهيم (على نبينا وآله وعليه الصلاة والسّلام) كالحج والعمرة، والختان وغسل الجنابة والميت، وكثير من محرّمات النكاح، وتعظيم البيت الحرام، واحترام إبراهيم نفسه، وغير ذلك.
ضرورة إحراج السلطة بموقف يلجئها لمغامرة سابقة لأوانها
وعلى ضوء ذلك لا علاج لمأساة الإسلام والمسلمين في تلك المرحلة الحساسة، إلّا بإحراج السلطة بموقف يستثيرها، ويفقدها توازنها، لتتخذ خطوة سابقة لأوانها، وتقوم بجريمة نكراء، تنكشف به على حقيقتها، تستفز جمهور
المسلمين، وتذكّرهم بدينهم ومبادئهم السامية، وتثير غضبهم، وتفصلهم عن السلطة فتخسر ثقتهم بها.
وبذلك تفقد السلطة فاعليتها في التثقيف، وقدرتها على التحريف، ويكون تعامل الجمهور معها تعامل الضعيف مع القوي، والمقهور مع القاهر، لا تعامل الرعية مع الراعي، والأتباع مع القائد.
سنوح الفرصة لاتخاذ الموقف المذكور بعد معاوية
ومن الظاهر أنّ الفرصة قد سنحت بعد معاوية لاتخاذ الموقف المذكور للأسباب التالية:
الأوّل : التحوّل في مسار السلطة، وفي معيار اختيار الخليفة، وفي شخص الخليفة بالنحو غير المألوف للمسلمين، ولا المقبول عندهم في وقته.
حيث يصلح ذلك مبرّراً لإعلان عدم الشرعية، والامتناع من البيعة، ثمّ التذكير بجرائم الأمويين عموماً، والإنكار عليهم وفضحهم.
الثاني : طيش يزيد، واعتماده القوة والعنف في مواجهة الأزمات ومعالجة المشاكل من دون تدبّر في العواقب وحساب لها، على خلاف ما كان عليه الأمر في عهد معاوية.
الثالث : وجود جماعة كبيرة مندفعة مبدئياً وعاطفياً نحو التغيير، مقتنعة بإمكانه، واثقة بالقيادة المعصومة، وتدعوها للعمل على ذلك، وتَعِدُها النصرة. حيث تتحقّق بتلك الجماعة آلية العمل، واتخاذ الموقف المذكور.
الرابع: أنّ فاجعة الطفّ - بأبعادها الدينية والعاطفية والإلهية التي تقدّم تفصيل الكلام فيها - كانت هي الجريمة الأحرى باستفزاز جمهور المسلمين
واستثارة غضبهم، وفصلهم عن السلطة وسلب ثقتهم بها.
كما إنّها الأحرى بأن تبقى عاراً على الأمويين ومَنْ يتبنّى خطّهم، ويتحمّلوا معرّتها ما بقيت الدنيا، كما صرّح بذلك الوليد بن عتبة بن أبي سفيان في كتابه المتقدّم لابن زياد الذي قال فيه: أمّا بعد، فإنّ الحسين بن علي قد توجّه إلى العراق، وهو ابن فاطمة، وفاطمة بنت رسول الله، فاحذر يابن زياد أن تأتي إليه بسوء، فتهيج على نفسك وقومك في هذه الدنيا ما لا يسدّه شيء، ولا تنساه الخاصّة والعامّة أبداً ما دامت الدنيا(١) .
وربما يفسّر ذلك ما تقدّم في حوار الإمام الحسين (صلوات الله عليه) مع أخيه محمد بن الحنفية حينما سأله عن وجه تعجيله بالخروج، فقال (عليه السّلام): «أتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما فارقتك، فقال: يا حسين اخرج؛ فإنّ الله قد شاء أن يراك قتيلاً». فقال محمد: إنّا لله وإنّا إليه راجعون. فما معنى حملك هؤلاء النسوة معك وأنت تخرج على مثل هذا الحال؟ فقال: «قد قال لي: إنّ الله قد شاء أن يراهنّ سبايا»(٢) .
وعلى كلّ حال فيتم بذلك الشوط الذي بدأه أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسّلام)، وصالح من أجله الإمام الحسن (صلوات الله عليه) - على ما يأتي في المقصد الثالث إن شاء الله تعالى - وصارع من أجل استمراره خواص الشيعة، وتحمّلوا في سبيله صنوف الأذى والتنكيل.
اقتحام السلطة له (عليه السّلام) يزيدها جرأة على انتهاك الحرمات
نعم، اقتحام السلطة للإمام الحسين (صلوات الله عليه) وانتهاكها لحرمته
____________________
١ - تقدّمت مصادره في/١٣٤.
٢ - تقدّمت مصادره في/٤٢.
يزيد في جرأتها على الحرمات، ويهون عليها كلّ جريمة، كما توقّعه هو (عليه السّلام) وغيره على ما سبق، وقد حصل فعلاً.
إلاّ إنّ ذلك إنّما يكون مضرّاً بالدين إذا حافظت السلطة على شرعيته، كما هو المتوقّع لو بايع الإمام الحسين (صلوات الله عليه)، وكسبت السلطة الشرعية عند جمهور المسلمين، وصفت لها الأمور.
حيث تسعى لتحقيق أهدافها، بانتهاك الحرمات والتخلّص من المعارضة بصورة تدريجية متّزنة، يستغفل بها الجمهور، ولا تفقدها الشرعية بنظرهم، وبذلك تنطمس معالم الدين الحقّ، وتخنق دعوته، ولا يُسمع صوته، كما تقدم.
استهتار السلطة بعد سقوط شرعيتها لا يضرّ بالدين
أمّا إذا فقدت السلطة شرعيتها وانفصلت عن الدين بنظر الجمهور؛ نتيجة قيامها بمثل هذه الجريمة النكراء، فتكون للتضحية ثمرتها المهمّة لصالح الدين، بل تكون فتحاً عظيماً تهون دونه هذه النتائج والسلبيات.
بل كلّما زاد الحاكم إمعاناً في الجريمة تأكّد عند الناس بعده عن الشرعية، وكلّما شعر هو بأنّ الناس لا تقتنع بشرعيته زاد استخفافاً بالدين وتجاهراً بمخالفته؛ لشعوره بعدم الفائدة من مجاملة الناس وستر أمره عليهم.
وذلك مكسب عظيم جدّاً للإسلام في تلك الظروف التي كان يمرّ بها؛ حيث يؤكّد عدم شرعية السلطة التي تحاول أن تقنع الناس بأنّها هي الممثّل له.
أثر الفاجعة في حدّة الخلاف بين الشيعة وخصومهم
كما إنّ فاجعة الطفّ قد أوجبت حدّة الخلاف بين شيعة أهل البيت وخصومهم وتعمّقها ولو على الأمد البعيد؛ نتيجة تركيز السلطات المتعاقبة
المخالفة لخطّ أهل البيت (صلوات الله عليهم) على احترام الأوّلين وموالاتهم والتديّن بشرعية خلافتهما، وشرعية نظام الخلافة الذي بدأ العمل عليه منهما، واهتزاز ذلك بسبب الفاجعة، على ما يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى.
دفع محاذير الاختلاف
لكن سبق منّا أن ذكرنا أنّه بعد أن تعذّر اتفاق المسلمين على الحقّ؛ نتيجة الانحراف الذي حصل، فاختلافهم في الحقّ خير من اتفاقهم على الباطل، ثمّ ضياع الحقّ عليهم وعلى غيرهم بحيث لا يمكن الوصول إليه(١) . ولاسيما إذا كان الاختلاف مشفوعاً بظهور معالم الدين الحقّ وسماع دعوته، وقوّة الحجّة عليه كما يأتي توضيحه إن شاء الله تعالى.
مواقف الأنبياء والأوصياء وجميع المصلحين
وعلى هذا جرى جميع الأنبياء والأوصياء (صلوات الله عليهم) وكلّ المصلحين، خصوصاً الأُمميين الذين تعمّ دعوتهم العالم أجمع، ولا تختص بمدينة خاصة أو قبيلة خاصة أو شعب خاص.
فإنّهم بدعوتهم وتحرّكهم قد خالفوا المحيط الذي عاشوا فيه، وشقّوا كلمة أهله، ولم يتيسّر لهم غالباً أو دائماً توحيد كلمة المعنيين بدعوتهم وحركتهم، وكسب اتفاقهم لصالحهم.
وأنجحهم من استطاع أن يوحّد جماعة صالحة تتمسّك بخطّه وتعاليمه وتدعوا إليها في مقابل دعوة الباطل التي كان يفترض لها أن تنفرّد في الساحة لولا نهضته وظهور دعوته.
____________________
(١) تقدم في ص: ٢١٧.
ولا مبرّر لهم في ذلك إلّا تنبيه الغافل، وإيضاح معالم الحقّ الذي يدعون له، وإقامة الحجّة عليه؛ ليتيسّر لطالب الحقّ الوصول إليه، كما قال الله (عزّ وجلّ):( إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُور ) (١) ، وقال سبحانه:( ليَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ ) (٢) .
المقارنة بين دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفاجعة الطفّ
وما الفرق بين دعوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وحركته التي تسببت عن اختلاف الناس عامّة في الدين الحقّ، ونهضة الإمام الحسين (صلوات الله عليه) التي عمّقت الخلاف بين المسلمين في تعيين الإسلام الحقّ، وكان لها أعظم الأثر في إيضاح معالمه؟!
وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نجح في قيام أُمّة تعتنق الإسلام، وتستظل برايته، فإنّ الإمام الحسين (عليه السّلام) قد كان له أعظم الأثر في نشاط الفرقة المحقّة التي تلتزم بالإسلام الحقّ المتمثل بخطّ أهل البيت (صلوات الله عليهم)، والتي تهتدي بهداهم، وتستضيء بنورهم، وفي قوّة هذه الفرقة وتماسكها كما يأتي توضيحه في المطلب الثاني إن شاء الله تعالى.
لا بدّ من حصول الخلاف بين المسلمين بسبب الانحراف
على أنّه بعد أن لم يتفق المسلمون على التمسّك بأهل البيت (صلوات الله عليهم)؛ ليعتصموا بهم من الخلاف والضلال، وانحراف مسار السلطة، فالإسلام - كسائر الأديان - معرض للخلاف والانشقاق، تبعاً لاختلاف الاجتهادات والآراء والمصالح والمطامع التي لا تقف عن حدّ.
____________________
١ - سورة الدهر/٣.
٢ - سورة الأنفال/٤٢.
ولأَن يكون الخلاف بين حق واضح المعالم، ظاهر الحجّة، وباطل مفضوح، يعتمد على السلطة والقوّة - كالذي حصل نتيجة جهود أهل البيت (عليهم السّلام) وشيعتهم وفي قمّتها نهضة الإمام الحسين (صلوات الله عليه) التي ختمت بفاجعة الطفّ - خير من أن تضيع معالم الحقّ، ثمّ يكون الصراع بين القوى المختلفة من أجل تثبيت مواقعها، وتحقيق أهدافها من دون هدى من الله (عزّ وجلّ)، ولا بصيرة في دينها، ومن دون مكسب للدين.
بل يأتي إن شاء الله تعالى أنّ لفاجعة الطفّ أعظم الأثر في بقاء معالم الدين حيث اتفق المسلمون بكيانهم العام على مشتركات كثيرة تحفظ للدين صورته ووحدته، ويكون الخارج عنها معزولاً عن الكيان الإسلامي العام بحيث قد يصل حدّ التكفير والخروج عن الدين، ولولا ذلك لانتشر الأمر، واتّسعت شقّة الخلاف من دون حدود ولا ضوابط.
محذور إضعاف الدولة العربية والإسلامية
ومثل ذلك ما قد يُقال من أنّ فاجعة الطفّ - بتداعياتها التي يأتي التعرّض لها - قد أضعفت الدولة العربية، أو الدولة الإسلامية؛ بسبب اهتزاز الكيان العربي والإسلامي، وظهور الانقسامات والشروخ فيها.
ولعلّ ذلك هو الذي يحمل كثيراً من الباحثين على التململ من نهضة الإمام الحسين (صلوات الله عليه) أو نقدها أو التهجّم عليها.
فإنّه يندفع بوجهين:
الدولة بتركيبتها معرّضة للضعف والانهيار
الأوّل: إنّ مثل هذه الدولة المبنية على الاستغلال والظلم والجبروت
والقهر، وعلى عدم الانضباط في نظام الحكم، معرّضة للصراع والضعف والانهيار، كما انهارت الدول بمرور الزمن مهما كانت قوّتها.
ولأن يكون الصراع داخل الدولة بين الحقّ والباطل، وتمتاز إحدى الفئتين عن الأخرى، خير من ضياع الحقّ وموته بمرور الزمن، ثمّ يكون الصراع بعد ذلك بين فئات الباطل المختلفة من أجل الاستيلاء على السلطة من دون هدف ديني أو إنساني نبيل.
لا أهمية للدولة العربية في منظور الإسلام
الثاني: إنّ كون الدولة عربية لا أهمية لها في منظور الدين الإسلامي العظيم، بل لا يخرج ذلك عن منظور جاهلي حاربه الإسلام، وشدّد في الإنكار عليه ونبذه.
وهو عدوان في حقيقته على الإسلام الذي قام عليه كيان الدولة، وسرقة منه؛ فإنّ كون العرب هم الحاكمين في تلك الفترة باسم الإسلام شيء، وكون الدولة عربية شيء آخر.
فهو نظير ما يُنسب لبعض الأمويين من قوله عن سواد العراق: إنّما هذا السواد بستان لأُغيلمة من قريش(١) . وما يُنسب للتعاليم اليهودية المحرّفة من أنّ الدين اليهودي مخصّص لصالح بني إسرائيل، ويقرّ امتيازاتهم على
____________________
١ - الطبقات الكبرى ٥/٣٢ في ترجمة سعيد بن العاص، واللفظ له، تاريخ دمشق ٢١/١١٤ - ١١٥ في ترجمة سعيد بن العاص، تاريخ الإسلام ٣/٤٣١ أحداث سنة خمس وثلاثين من الهجرة، مقتل عثمان (رضي الله عنه)، ونحوه في تاريخ الطبري ٣/٣٦٥ أحداث سنة ثلاث وثلاثين من الهجرة، ذكر تسيير عثمان من سير من أهل الكوفة إلى الشام، والكامل في التاريخ ٣/١٣٩ أحداث سنة ثلاث وثلاثين من الهجرة، ذكر تسيير عثمان من سير من أهل الكوفة إلى الشام، وتاريخ ابن خلدون ٢ ق ٢/١٤٠، وشرح نهج البلاغة ٣/٢١، وغيرها من المصادر.
بقية الشعوب.
لو شكر العرب النعمة
نعم، لو أنّ العرب شكروا نعمة الله (عزّ وجلّ) ولم يخرجوا بالسلطة عن موضعها الذي وضعها الله تعالى فيه، ووفوا بعهد الله سبحانه الذي أخذه عليهم، لأبقى الله (جلّ شأنه) عزّهم فيهم، ولحملوا دعوة الله (عزّ وجلّ) للأمم، وانتشر الإسلام بحقّه وحقيقته، وعدله واستقامته، وخيره وبركته، بعيداً عن الانحراف والاستغلال والمحسوبيات.
ولعمّت لغة العرب الدنيا، لا لأنّها لغة العرب؛ لتتحسّس منها الشعوب الأخرى، بل لأنّها لغة الدين العظيم والقرآن المجيد والسُنّة الشريفة - بما في ذلك الأدعية والزيارات الكثيرة - وبقية التراث الإسلامي.
وبذلك تُهمل الفوارق تدريجاً، وتموت العصبيات، ويكون للعرب شرف ذلك كلّه، ويكسبون احترام العالم ومودّته.
لكنّهم أخطأوا حظّهم، وضيّعوا نصيبهم، و( بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللهِ كُفْراً وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ) (١) فكان عاقبة أمرهم خسراً.
وإلى ذلك يشير عمار بن ياسر رضي الله عنه في كلام له يوم الشورى بعد صرف الأمر عن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) وبيعة عثمان. فقد روى الجوهري قال: «نادى عمار بن ياسر ذلك اليوم: يا معشر المسلمين، إنّا كنّا وما كنّا نستطيع الكلام قلة وذلة، فأعزنا الله بدينه، وأكرمنا برسوله. فالحمد لله رب العالمين. يا معشر قريش، إلى متى تصرفون هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم، تحولونه ههنا مرة، وههنا مرة؟! ما أنا آمن أن ينزعه منكم ويضعه في غيركم، كما نزعتموه من
____________________
١ - سورة إبراهيم/٢٨.
أهله ووضعتموه في غير أهله»(١) . وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولله أمر هو بالغة.
إظهار دعوة الإسلام الحقّ أهم من قوّة دولته
أمّا كون الدولة إسلامية فهو من الأهمية بمكان، خصوصاً في تلك الظروف؛ حيث تكون سبباً في حفظ كيان الإسلام، وإيصال دعوته الشريفة للعالم، كما حصل فعلاً؛ ولذا تقدّم أنّ أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) ترك الصراع مع القوم لاسترجاع حقّه حفاظاً على كيان الإسلام العام.
إلاّ إنّ من أهم الثمرات المطلوبة من بقاء الكيان الإسلامي العام هو تحقيق الأرضية الصالحة لإيصال الإسلام الحقّ للمسلمين، بل للعالم عامّة وتعرّفهم به، فلا معنى للتفريط بهذه الثمرة حذراً من ضعفٍ مؤقت في قوّة الدولة الإسلامية التي هي في مقام تحريف الدين وتضييع معالمه.
بل يتعين إيقاف الدولة عند حدّها، والسعي لسلب شرعيتها؛ لتعجز عن تحريف الدين وتضييع معالمه، ثمّ تترك لتقوّي كيانها باسم الإسلام من دون أن تقوى على التدخّل في الدين؛ لحفظ معالمه، واتضاح ضوابطه مع ظهور دعوة الدين الحقّ وقوّته، وسماع صوتها في ضمن الكيان الإسلامي العام.
وهو ما حصل بجهود أهل البيت (صلوات الله عليهم)، وفي قمّتها نهضة الإمام الحسين (عليه السّلام) التي انتهت بفاجعة الطفّ المدوّية الخالدة.
والحاصل: إنّه قد كان لفاجعة الطفّ التي ختمت بها نهضة الإمام الحسين (صلوات الله عليه) - الذي هو المسؤول الأوّل في المسلمين - في هذا المفصل التاريخي من مسار السلطة، والوضع الحرج الذي يمرّ به الإسلام، ضرورة
____________________
(١) شرح نهج البلاغة ج: ٩ ص: ٥٨. ونظيره في مروج الذهب ج: ٢ ص: ٣٤١ ذكر خلافة عثمان بن عفان: عمار بن ياسر.
ملحة من أجل التنفير من السلطة المنحرفة، وسلب الشرعية عنها؛ لدفع غائلتها عن الإسلام، ومن أجل إيضاح معالم الدين والتذكير بضوابطه.
حقّقت فاجعة الطفّ هدفها على الوجه الأكمل
وقد حقّقت هدفها على أكمل وجه؛ حيث صارت الفاجعة - بأبعادها المتقدّمة - صرخة مدوّية هزّت ضمير الأُمّة، ونبّهتها من غفلتها، وأشعرتها بالخيبة والخسران؛ لخذلان الحقّ ودعم الباطل، وبالهوّة السحيقة بين الواقع الذي تعيشه، والواقع الديني الذي أراد الله (عزّ وجلّ) منها أن تكون عليه.
ولاسيما مع قرب العهد النبوي الشريف وعهد أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)؛ حيث يتجسّد الإسلام الحقّ على الأرض، ولا يزال المسلمون يتذكّرونه ويتحدّثون عنه.
وبذلك تزعزعت الأسس التي قام عليها كيان الظالمين، وابتنت عليها شرعية حكمهم، وسعة صلاحياتهم، وتأثيرهم في تثقيف الأُمّة وتوجيهها.
وقد سبق أنّ السلطة بعد انحراف مسارها في الإسلام - باستيلاء غير المعصوم المنصوص عليه على الحكم - قد حاولت في الصدر الأوّل تمرير مشروع تدويل الإسلام الذي يُراد به تبعية الدين الإسلامي للدولة والسلطة بحيث يؤخذ منها، وتكون هي المرجع فيه، ويتيسّر لها التحكّم فيه لصالحها، وتبعاً لأهوائها.
وإذا كان أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسّلام) في فترة حكمه القصيرة قد وقف في وجه المشروع المذكور، وأصحر بمقاومته وعدم شرعيته، واستمرّ خواص شيعته في صراع مرير ضدّه؛ فإنّ الإمام الحسين (صلوات الله عليه) قد اغتنم الفرصة للإجهاز على المشروع المذكور، والقضاء عليه تماماً
بفاجعة الطفّ الدامية؛ حيث قامت السلطة بأفظع جريمة في تاريخ الإسلام، لا يزال صداها مدوياً حتى اليوم، وبذلك تمّ الفتح على يديه (صلوات الله عليه).
هذا وقد سبق منّا(١) في المقصد الأوّل التعرّض في تتمّة الكلام في أبعاد الفاجعة وعمقها إلى ردود الفعل السريعة للفاجعة، وتأثيرها على موقف السلطة نفسها بعد شعورها بالخطأ والخيبة.
تداعيات فاجعة الطفّ في المراحل اللاحقة
ويحسن منّا هنا التعرّض لتداعيات الفاجعة في المراحل اللاحقة، وتأثيرها على موقف جمهور المسلمين وخاصتهم من السلطة؛ من أجل أن يتضح كيف سارت الأمور في اتجاه الفتح العظيم، وتحقيق أهداف تلك الملحمة الإلهية المباركة، فنقول بعد الاتكال على الله (عزّ وجلّ) وطلب التسديد منه:
ثورة أهل المدينة وعبد الله بن الزبير
من المعلوم أنّ من نتائج فاجعة الطفّ وتداعياتها السريعة الثورات المتلاحقة، والخروج على حكم يزيد من أهل المدينة المنوّرة الذي انتهى بواقعة الحرّة الفظيعة، ومن عبد الله بن الزبير الذي أدّى لانتهاك الأمويين حرمة الحرم، ورميهم مكة المكرّمة بالمنجنيق حتى أُصيبت الكعبة المعظمة واحترقت(٢) .
____________________
١ - راجع/٩٣ وما بعده.
٢ - الكامل في التاريخ ٤/١٢٤ أحداث سنة أربع وستين من الهجرة، ذكر مسير مسلم لحصار ابن الزبير وموته، تاريخ الطبري ٤/٣٨٣ أحداث سنة أربع وستين من الهجرة، البداية والنهاية ٨/٢٤٧ أحداث سنة أربع وستين من الهجرة، السيرة الحلبية ١/٢٩٠، تاريخ دمشق ١٤/٣٨٥ في ترجمة حصين بن نمير، تاريخ الإسلام ٥/٣٤ حوادث سنة أربع وستين من الهجرة، تاريخ اليعقوبي ٢/٢٦٦ أيام مروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير، الوافي بالوفيات ج: ١٣ =
موت يزيد بن معاوية
وبعد ذلك عجّل الله تعالى على يزيد وأهلكه، وقد مقته الناس وأبغضوه حتى إنّ ابن زياد لما نعاه إلى أهل البصرة نال منه وثلبه(١) ، وما ذلك إلّا لإرضائهم، طمعاً في ودّهم وكسبهم لصالحه.
إعلان معاوية بن يزيد عن جرائم جدّه وأبيه
وكان يزيد قد عهد بالخلافة من بعده لابنه معاوية، فأعلن معاوية عن جرائم جدّه وأبيه بنحو يوحي بعدم شرعية خلافتهم، ثمّ رفض تحمّل مسؤولية الخلافة، وتعيين ولّي العهد له.
فقد خطب الناس، وقال في جملة ما قال: ألا وإنّ جدّي معاوية بن أبي سفيان نازع الأمر مَنْ كان أولى به منه في القرابة برسول الله، وأحق في الإسلام، سابق المسلمين، وأوّل المؤمنين، وابن عمّ رسول ربّ العالمين، وأبا بقيّة خاتم المرسلين. فركب منكم ما تعلمون، وركبتم منه ما لا تنكرون حتى أتت منيّته، وصار رهناً بعمله.
ثمّ قلّد أبي وكان غير خليق للخير، فركب هواه، واستحسن خطأه، وعظم رجاؤه، فأخلفه الأمل، وقصر عنه الأجل؛ فقلّت منعته، وانقطعت مدّته، وصار
____________________
= ص: ٥٧ في ترجمة حصين السكوني، تهذيب التهذيب ٥/١٨٨ في ترجمة عبد الله بن الزبير بن العوام، فتح الباري ٣/٣٥٤، و٨/٢٤٥، إمتاع الأسماع ١٢/٢٧٢، تعجيل المنفعة/٤٥٣، وغيرها من المصادر الكثيرة.
١ - الكامل في التاريخ ٤/١٣١ أحداث سنة أربع وستين من الهجرة، ذكر حال ابن زياد بعد موت يزيد، تاريخ الطبري ٤/٣٨٩ أحداث سنة خمس وستين من الهجرة، ذكر الخبر عمّا كان من أمر عبيد الله بن زياد وأمر أهل البصرة معه بها بعد موت يزيد، تاريخ دمشق ١٠/٩٥ في ترجمة أيوب بن حمران، وغيرها من المصادر.
في حفرته، رهناً بذنبه، وأسيراً بجرمه.
ثمّ بكى وقال: إنّ أعظم الأمور علينا علمنا بسوء مصرعه، وقبح منقلبه، وقد قتل عترة رسول الله، وأباح الحرمة، وحرق الكعبة.
وما أنا بالمتقلّد أموركم، ولا المتحمّل تبعاتكم؛ فشأنكم أمركم. فوالله، لئن كانت الدنيا مغنماً لقد نلنا منها حظّاً، وإن تكن شرّاً فحسب آل أبي سفيان ما أصابوا منها.
فقال له مروان بن الحكم: سنّها فينا عمرية. قال: ما كنت أتقلدكم حيّاً وميتاً. ومتى صار يزيد بن معاوية مثل عمر؟! ومَنْ لي برجل مثل رجال عمر؟!
هذا ما رواه اليعقوبي(١) ، وذكر قريباً منه باختصار المقدسي(٢) . أمّا ما رواه الدميري(٣) وابن الدمشقي(٤) والعصامي(٥) فهو أظهر في تعظيم أمير المؤمنين وأهل البيت (صلوات الله عليهم) وبيان حقّهم، بل فيه تلويح أو تصريح بظلمهم (عليهم السّلام) حتى من قِبَل الأوّلين.
وقال البلاذري: وحدّثني هشام بن عمّار عن الوليد بن مسلم قال: دخل مروان بن الحكم على معاوية بن يزيد فقال له: لقد أعطيت من نفسك ما يُعطي
____________________
١ - تاريخ اليعقوبي ٢/٢٥٤ أيام معاوية بن يزيد بن معاوية، واللفظ له، وقريب منه في النجوم الزاهرة ١/٦٥ ولاية سعيد بن يزيد على مصر، وينابيع المودة ٣/٣٧.
٢ - البدء والتاريخ ٦/١٦ - ١٧ ولاية معاوية بن يزيد بن معاوية.
٣ - حياة الحيوان/١١٢ في مادة: أوز في خلافة معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان.
٤ - جواهر المطالب ٢/٢٦١ - ٢٦٢ الباب الثاني والسبعون في ذكر الوافدات على معاوية بعد قتل علي (عليه السّلام) وما خاطبوه به وما أسمعوه، خطبة معاوية بن يزيد بن معاوية.
٥ - سمط النجوم العوالي ٣/١٠٢، وفاة يزيد وبيعة معاوية ابنه وملكه.
الذليل المهين. ثمّ رفع صوته فقال: مَنْ أراد أن ينظر في خالفة آل حرب فلينظر إلى هذا.
فقال له معاوية: يابن الزرقاء! اخرج عنّي، لا قَبِل الله لك عذراً يوم تلقاه(١) .
ولم يطل عهده، بل بقي عشرين يوماً(٢) أو أربعين يوماً(٣) أو ثلاثة أشهر(٤) أو أربعة(٥) ، وقيل: إنّه مات مطعوناً(٦) ، وقيل: مات مسموماً(٧) ولعلّه الأشهر.
____________________
١ - أنساب الأشراف ٥/٣٨١ في ترجمة معاوية بن يزيد.
٢ - أنساب الأشراف ٥/٣٧٩ في ترجمة معاوية بن يزيد، تاريخ دمشق ٥٩/٣٠٠ في ترجمة معاوية بن يزيد بن معاوية، البدء والتاريخ ٦/١٧ ولاية معاوية بن يزيد بن معاوية.
٣ - صحيح ابن حبان ١٥/٣٩ كتاب التاريخ، باب إخباره صلى الله عليه وآله وسلم عمّا يكون في أُمته من الفتن والحوادث، بيان سني الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الطبقات الكبرى ٤/١٦٩ في ترجمة عبد الله بن عمر بن الخطاب، و٥/٣٩ في ترجمة مروان بن الحكم، الاستيعاب ٣/١٣٨٩ في ترجمة مروان بن الحكم، أنساب الأشراف ٥/٣٧٩ في ترجمة معاوية بن يزيد، تاريخ دمشق ٥٧/٢٥٩ في ترجمة مروان بن الحكم، و٥٩/٢٩٧ في ترجمة معاوية بن يزيد بن معاوية، حياة الحيوان/١١٢ في مادة: أوز في خلافة معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، تاريخ خليفة بن خياط/١٩٦، البدء والتاريخ ٦/١٧ ولاية معاوية بن يزيد بن معاوية، شرح نهج البلاغة ٦/١٥٢، وغيرها من المصادر الكثيرة.
٤ - الطبقات الكبرى ٥/٣٩ في ترجمة مروان بن الحكم، أنساب الأشراف ٥/٣٧٩ في ترجمة معاوية بن يزيد، تاريخ دمشق ٥٧/٢٥٩ في ترجمة مروان بن الحكم، البدء والتاريخ ٦/١٧ ولاية معاوية بن يزيد بن معاوية، سير أعلام النبلاء ٤/١٣٩ في ترجمة معاوية بن يزيد، الكامل في التاريخ ٤/١٣٠ أحداث سنة أربع وستين من الهجرة، ذكر بيعة معاوية بن يزيد بن معاوية، وغيرها من المصادر الكثيرة.
٥ - تاريخ دمشق ٥٩/٣٠٥ في ترجمة معاوية بن يزيد بن معاوية، البداية والنهاية ٨/٢٦٠ أحداث سنة أربع وستين من الهجرة، إمارة معاوية بن يزيد بن معاوية، تاريخ اليعقوبي ٢/٢٥٤ في أيام معاوية بن يزيد بن معاوية.
٦ - البداية والنهاية ٨/٢٦١ أحداث سنة أربع وستين من الهجرة، إمارة معاوية بن يزيد بن معاوية.
٧ - تاريخ الطبري ٤/٤٠٩ أحداث سنة أربع وستين من الهجرة: مبايعة أهل الشام لمروان بن الحكم. =
انتقام الأمويين من مؤدّب معاوية بن يزيد
وسواء انتقم منه الأمويون بالسّم، أم لم ينتقموا؛ فإنّهم قد انتقموا من مؤدّبه عمر بن نعيم العنسي المعروف بالمقصوص(١) فدفنوه حياً(٢) .
وقال الدميري: ثمّ إنّ بني أمية قالوا لمؤدّبه عمر المقصوص: أنت علّمته هذا ولقّنته إيّاه، وصددته عن الخلافة، وزيّنت له حبّ علي وأولاده، وحملته على ما وسمنا به من الظلم، وحسنت له الباع حتى نطق بما نطق، وقال ما قال. فقال: والله ما فعلته، ولكنّه مجبول ومطبوع على حبّ علي. فلم يقبلوا منه ذلك، وأخذوه ودفنوه حيّاً حتى مات(٣) .
وذكره مختصراً ابن الدمشقي، لكنّه قال: فقال: لا والله، وإنّه لمطبوع عليه. والله ما حلف قطّ إلّا بمحمد وآل محمد، وما رأيته أفرد محمداً منذ عرفته(٤) .
____________________
= البداية والنهاية ٨/٢٦١ أحداث سنة أربع وستين من الهجرة، إمارة معاوية بن يزيد بن معاوية، الكامل في التاريخ ٤/١٣٠ أحداث سنة أربع وستين من الهجرة، ذكر بيعة معاوية بن يزيد بن معاوية، سمط النجوم العوالي ٣/١٠١ وفاة يزيد وبيعة معاوية ابنه وملكه، الفخري في الآداب السلطانية ١/٤٣ في ترجمة معاوية بن يزيد، نهاية الأرب في فنون الأدب ٢٠/٣١٣ أحداث سنة ثلاثة وستين من الهجرة، ذكر بيعة معاوية بن يزيد بن معاوية.
١ - جواهر المطالب ٢/٢٦٢.
٢ - البدء التاريخ ٦/١٧ ولاية معاوية بن يزيد بن معاوية، تاريخ مختصر الدول/١١١ الدولة التاسعة: معاوية بن يزيد، سمط النجوم العوالي ٣/١٠٢ وفاة يزيد وبيعة معاوية ابنه وملكه، تاريخ الخميس ٢/٣٠١ خلافة معاوية بن يزيد بن معاوية.
٣ - حياة الحيوان/١١٢ في مادة: أوز في خلافة معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، واللفظ له، سمط النجوم العوالي ٣/١٠٢ وفاة يزيد وبيعة معاوية ابنه وملكه.
٤ - جواهر المطالب ٢/٢٦١ - ٢٦٢ الباب الثاني والسبعون في ذكر الوافدات على معاوية بعد قتل علي (عليه السّلام) وما خاطبوه به وما أسمعوه، خطبة معاوية بن يزيد بن معاوية.
انهيار دولة آل أبي سفيان
وكيف كان فالذي لا ريب فيه أنّه لم يعهد لأحد من بعده بالخلافة.
وبذلك انهارت دولة آل معاوية أو آل أبي سفيان، تلك الدولة العظمى التي جهد معاوية بدهائه ومكره، وجرائمه وموبقاته وقوّة سلطانه في إرساء قواعدها وإحكام بنيانها، وبنى عليها آمالاً طويلة عريضة( كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ) (١) .
اختلاف الأمويين وتعدد الاتجاهات في العالم الإسلامي
وقد استتبع ذلك اختلاف الأمويين فيما بينهم، وتعددت الاتجاهات في المسلمين، كما قال المساور بن هند بن قيس: وتشعّبوا شعب، فكلّ قبيلة فيها أمير المؤمنين(٢) .
حيث ظهر التوّابون، ثمّ المختار، ونشط ابن الزبير والخوارج، ورفع غير واحد رأسه في المناطق الإسلامية المختلفة، وقد أُريق بسبب ذلك أنهار من الدماء، وانتُهكت كثير من الحرمات، وعمّ الهرج والمرج.
تنبؤ الصديقة فاطمة (عليها السّلام) بما آلت إليه الأمور
وكأنّه إلى ذلك وأمثاله ممّا حصل للمسلمين في مفاصل تاريخية كثيرة تنظر الصديقة فاطمة الزهراء (صلوات الله عليها) في قولها المتقدّم في ختام خطبتها الصغيرة، تعقيباً على انحراف مسار السلطة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أما لعمري، لقد
____________________
١ - سورة النور/٣٩.
٢ - تاريخ اليعقوبي ٢/٢٦٣ أيام مروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير.
لقحت فنظرة ريثما تنتج، ثمّ احتلبوا ملأ القعب دماً عبيطاً، وزعافاً مبيداً، هنالك( يَخسَرُ المُبطِلُونَ ) ، ويعرف البطالون غبّ ما أسس الأوّلون، ثمّ طيبوا عن دنياكم أنفساً، وأطمئنوا للفتنة جأشاً، وأبشروا بسيف صارم، وسطوة معتد غاشم، وبهرج شامل، واستبداد من الظالمين يدع فيئكم زهيداً، وجمعكم حصيداً...»(١) .
أهمية الفترة الانتقالية التي استمرت عشر سنين
ولم يستقر الأمر لعبد الملك بن مروان نسبياً إلّا بعد قتل عبد الله بن الزبير سنة ثلاث وسبعين، في السنة الثالثة عشرة لفاجعة الطفّ ومقتل الإمام الحسين (صلوات الله عليه).
وقد كان لهذه الفترة الانتقالية - التي استمرت عشر سنين تقريباً - أهمية كبرى من جهتين:
وضوح عزل الدين في الصراع على السلطة وفي كيانها
الجهة الأولى: وضوح تجرّد السلطة عن الدين والمبادئ في صراعها مع الآخرين، وفي سلوكها مع الرعية؛ وقد تجلّى ذلك على أتمّ وجه فيمَنْ كانت له الغلبة أخيراً، وهم آل مروان بن الحكم بن العاص الذين هم من أبعد الناس عن واقع الإسلام، وأسوئهم أثراً فيه.
وقد صدق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلاً اتّخذوا مال الله دولاً، وعباد الله خولاً، ودين الله دغلاً»(٢) .
____________________
١ - راجع ملحق رقم (٢).
٢ - المستدرك على الصحيحين ٤/٤٨٠ كتاب الفتن والملاحم، واللفظ له، مسند أبي يعلى ١١/٤٠٢ ح ٦٥٢٣، مجمع الزوائد ٥/٢٤١ كتاب الخلافة، باب في أئمّة الظلم والجور وأئمّة الضلالة، المعجم الصغير ٢/١٣٥، سير أعلام النبلاء ٣/٤٧٨ في ترجمة مروان بن =
وقد أمعنوا في الاستهتار بالدين، والخروج على المبادئ الشريفة، وانتهاك الحرمات العظام في سبيل الاستيلاء على السلطة والاستئثار بالحكم.
كما أكّدوا واقع الأمويين الأسود بسوء سلطانهم وجبروتهم وطغيانهم، واستهتارهم وانتهاكهم للحرمات ومقارفتهم للموبقات واستغراقهم في الشهوات.
وقد أثار ذلك التوجّس والحذر والنقد لكلّ سلطة تُفرض، بل البغض والتنفّر منها نوعاً حتى سقطت حرمة السلطة، وفقدت قدسيتها عند جمهور المسلمين.
فالخليفة عندهم لا يمثّل الحقيقة الدينية المقدّسة وإن حاول أن يدّعي لنفسه ذلك، ويطلق عليها ألقاب الاحترام والتقديس، كخليفة الله، وسلطانه في الأرض، وخليفة رسوله، وأمير المؤمنين... إلى غير ذلك.
غاية الأمر أنّ التعامل وتمشية الأمور يكون معه؛ تبعاً للقوّة، رضوخاً للأمر الواقع، وانسجاماً معه في شرعية مهزوزة مادامت القوّة من دون إيمان بها في الأعماق، فضلاً عن التقديس المفترض لمقام الخلافة والإمامة. وكلّما زاد إجراماً وانتهاكاً للحرمات زاد بُعداً عن الحقيقة الدينية.
والحاصل: إنّه سبق أنّ الكتاب المجيد والسُنّة النبوية الشريفة قد أكّدا على وجوب معرفة الأئمّة، وفرض طاعتهم وموالاتهم والنصيحة لهم، ولزوم جماعتهم، وحرمة الخروج عليهم، وسقوط حرمة الخارج بحيث يكون باغياً يجب على المسلمين قتاله... إلى غير ذلك ممّا يفترض أن يترتّب عليه انشداد جمهور المسلمين للخلفاء وتقديسهم لهم بحيث يكونون هم الممثلين للدين
____________________
= الحكم، تاريخ الإسلام ٥/٢٣٣ في ترجمة مروان بن الحكم، تاريخ دمشق ٥٧/٢٥٣ في ترجمة مروان بن الحكم بن أبي العاص، إمتاع الأسماع ١٢/٢٧٦، كنز العمال ١١/١١٧ ح ٣٠٨٤٦، وص ١٦٥ ح ٣١٠٥٧، وغيرها من المصادر.
بنظرهم والقدوة التي يقتدون بها في حياتهم.
وقد حاول الأوّلون بمختلف الوسائل، وبجهود مكثّفة استغلال ذلك كلّه لصالحهم، ونجحوا في ذلك نسبياً، كما يظهر ممّا سبق.
إلاّ إنّ الصراع الذي بدأه أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)، واستمر عليه خواص شيعته، وتحمّلوا صنوف الأذى والتنكيل من أجله، وختم بفاجعة الطفّ وتداعياتها، كلّ ذلك قد جعل من واقع الخلفاء بنظر جمهور المسلمين أمراً لا ينسجم مع شيء من ذلك.
بل هم ينظرون لهم كذئاب كاسرة لا يؤمنون على دنيا ولا دين، وأصبح تقييمهم للخليفة منوطاً بعمله وسلوكه معهم من دون صبغة دينية ترفع من شأنه، وتجعلهم يتفاعلون معه.
اتضاح أنّ بيعة الخليفة لا تقتضي شرعية خلافته
كما إنّ البيعة للخليفة - حتى من الخاصة - لا تعني إضفاء الشرعية على خلافة الخليفة، بل الرضوخ له والتعايش معه؛ دفعاً لشرّه، وتقيّة منه.
أوّلاً : لتبلور مفهوم التقيّة تدريجاً نتيجة إفراط الخلفاء في الظلم والجبروت والطغيان، نظير ما تقدّم من الإمام علي بن الحسين زين العابدين (صلوات الله عليه) حول البيعة التي طلبها مسلم بن عقبة بعد واقعة الحرّة(١) .
وثانياً : لتسافل أمر الخلافة بتسافل وسائل الوصول إليه، وتحوّلها إلى سلطة قمع لتثبيت الطغاة.
وثالثاً : لتسافل واقع الخلفاء، ونزولهم للحضيض، وتوحّلهم في مستنقع
____________________
١ - تقدّم في/٣٥٦.
الجريمة والرذيلة والخلاعة والتحلل.
ومثل هذه الخلافة لا يمكن الاقتناع بشرعيتها من كلّ مسلم مهما كان التزامه الديني وثقافته، وإن كان يتعامل معها كأمر واقع مفروض عليه.
وإذا كان معاوية في حديثه المتقدّم(١) مع المغيرة بن شعبة قد استصعب الولاية بالعهد ليزيد لما يعرفه من واقعه المشين، ولبقاء شيء من الحرمة للخلافة، فإنّ الأمر بعد ذلك لم يعد صعباً؛ لسقوط حرمة الخلافة، وتحوّلها إلى أداة قمع ووسيلة للترف والاستهتار.
اتضاح أنّ وجوب الطاعة ولزوم الجماعة لا يعني الانصياع للسلطة
وقد اضطر ذلك رجال الدين والفقهاء - فيما بعد - إلى أن يفصحوا بحرمة طاعة السلطة في معصية الله تعالى(٢) ؛ لأنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
كما إنّ الجماعة التي يجب لزومها، ولا يجوز الخروج عنها ليست هي جماعة الخليفة الحاكم كما كان عليه الأمر في الصدر الأوّل، وحاول الحكّام التشبّث به على طول الخطّ، بل هي جماعة الحقّ أين كان، وكيف كان.
قال أبو شامة: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة، فالمراد لزوم الحقّ واتّباعه وإن كان المتمسّك به قليلاً والمخالف كثيراً؛ لأنّ الحقّ هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه (رضي الله عنهم)، ولا ننظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم(٣) .
____________________
١ - تقدّم في/٣٤٦.
٢ - المغني - لابن قدامة ٩/٤٧٩، بدائع الصنائع ٧/١٠٠، الثمر الداني/٢٤، كشاف القناع - للبهوتي ٥/٦١١، جواهر العقود - للمنهاجي الاسيوطي ٢/٢٨٠، فقه السنة ٢/٦٤٣ - ٦٤٤، عمدة القارئ ١٤/٢٢١، تحفة الأحوذي ٥/٢٩٨، وغيرها من المصادر.
٣ - شرح العقيدة الطحاوية - لابن أبي العزّ الحنفي/٣٠٧ - ٣٠٨، واللفظ له، فيض القدير ٤/١٣١، النصائح الكافية/٢١٩.
وقد استحسن ذلك منه ابن أبي العزّ الحنفي(١) .
وقال أبو حاتم: الأمر بالجماعة بلفظ العموم، والمراد منه الخاص؛ لأنّ الجماعة هي إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمَنْ لزم ما كانوا عليه وشذّ عمّنْ بعدهم لم يكن بشاقٍّ للجماعة، ولا مفارقٍ لها، ومَنْ شذّ عنهم وتبع مَنْ بعدهم كان شاقّاً للجماعة. والجماعة بعد الصحابة هم أقوام اجتمع فيهم الدين والعقل والعلم، ولزموا ترك الهوى فيما هم فيه وإن قلّت أعدادهم، لا أوباش الناس ورعاعهم وإن كثروا(٢) ، ونحوه كلام غيرهم.
بل بلغ الأمر بهم أنّهم رووا تفسير الجماعة التي يجب لزومها بالسواد الأعظم(٣) ، ومع ذلك قال إسحاق بن راهويه: لو سألت الجهّال عن السواد الأعظم قالوا: جماعة الناس. ولا يعلمون أنّ الجماعة عالم متمسّك بأثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمَنْ كان معه وتبعه فهو الجماعة، ومَنْ خالفه فيه ترك الجماعة(٤) .
تخبّط الجمهور في تحديد وجوب الطاعة ولزوم الجماعة
نعم، هذا منهم تخبّط في تحديد وجوب الطاعة ولزوم الجماعة؛ لظهور أنّه بعد أن وجبت عندهم البيعة للخليفة؛ لأنّ مَنْ مات من دون بيعة مات ميتة جاهلية كما تظافرت به النصوص، ولتوقّف حفظ كيان الإسلام وإدارة أمور المسلمين على الخلافة والإمامة، فمن الظاهر أنّ الإمامة لا تؤدّي وظيفتها إلّا بالطاعة، وأي خليفة وإمام يستطيع حفظ كيان الإسلام وإدارة أمور المسلمين
____________________
١ - شرح العقيدة الطحاوية - لابن أبي العزّ الحنفي/٣٠٧ - ٣٠٨.
٢ - صحيح ابن حبان ١٤/١٢٦ - ١٢٧ كتاب التاريخ، باب بدء الخلق، ذكر تشبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عيسى بن مريم بعروة بن مسعود.
٣ - فتح الباري ١٣/٣١، عمدة القاري ٢٤/١٩٥، تحفة الأحوذي ٦/٣٢١.
٤ - حلية الأولياء ٩/٢٣٨ في ترجمة محمد بن أسلم.
إذا كان لا يُطاع؟!
مع إنّ تمييز تصرّفات الخليفة المحلّلة من المحرّمة لا يتيسّر لعامة الناس، وحتى الخاصة كثيراً ما يختلفون في ذلك، وفي ذلك اضطراب أمور المسلمين، وانفراط نظمهم، وهو الذي حصل فعلاً.
كما إنّ الجماعة فيما يبدو من نصوصها - ومنها خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد الخيف المتقدّمة في أوائل المبحث الأوّل(١) - هي جماعة الخليفة والإمام الذي يقوم به كيان الإسلام، وينتظم المجتمع الإسلامي.
وببيان آخر: لزوم الجماعة إنّما ورد من أجل أن تكون الجماعة علماً على الحقّ، يعتصم به المسلمون، فإذا توقّف وجوب لزوم الجماعة على إحراز كونها جماعة حقّ لم تكن الجماعة علماً على الحقّ يعتصم به المسلمون، بل يعتصمون بالحقّ الذي لا بدّ لهم من معرفته قبل أن يعتصموا بالجماعة، كما لا يقوم بها كيان الإسلام؛ لخفاء الحقّ على جمهور الناس، واختلاف الخاصة فيه.
تناسق مفهوم الإمامة والطاعة والجماعة عند الإمامية
ولا مخرج عن ذلك إلّا بما سبق من أنّ المراد بالجماعة جماعة الإمام الحقّ، بعد الفراغ عن أنّ الله (عزّ وجلّ) قد عيّن الإمام الحقّ المعصوم بالنصّ الواضح الجلي الذي يجب على الأُمّة التسليم له، كما عليه الإمامية في أئمّة أهل البيت (صلوات الله عليهم).
والإمام المذكور هو الذي تجب طاعته ولزوم جماعته، ولا يجوز الخروج عليه، ومَنْ لا تجب طاعته ولزوم جماعته على الإطلاق؛ لعدم عصمته لا بدّ أن لا يكون ممّا عند الله تعالى بحيث تجري عليه أحكام الإمام الشرعية.
____________________
١ - تقدّمت مصادرها في/١٥٧.
وقد تقدّم بعض الكلام في ذلك عند التعرّض لجهود أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في كشف الحقيقة، وبيان معالم الدين في المقام الأوّل من هذا المبحث(١) .
إلاّ إنّ الجمهور حيث لم يقرّوا بالنصّ، ولم يذعنوا له - وذهبوا إلى أنّ الإمامة والخلافة تكون ببيعة الناس من دون ضابط -، ولم يمكنهم البناء على وجوب طاعة الخليفة، ولزوم جماعته مطلقاً وإن كان فاسقاً جائراً - نتيجة ما سبق -؛ اضطروا لهذا التخبط.
والمهم في المقام أنّ ضوابط الطاعة ولزوم الجماعة قد اهتزّت، واختلفت عمّا كانت عليه قبل فاجعة الطفّ كما يظهر بمراجعة ما سبق من الصدر الأوّل في التأكيد على لزوم الجماعة.
وقد اضطروا أخيراً للالتزام نظرياً بعدم وجوب الطاعة المطلقة لخليفة الجور، وإن كانوا كثيراً ما لا يجرون على ذلك عملياً؛ غفلة منهم أو تغافلاً.
وترتّب على ذلك أمران في غاية الأهمية:
الخروج على السلطة لم يَعُدْ يختصّ بالخوارج
الأوّل : إنّ الخروج على الحاكم لا يختص بالخوارج الذين تشوهّت صورتهم، وسقط اعتبارهم؛ من أجل ما سبق، بل خرج كثير من غيرهم على السلطات المتعاقبة، وفيهم مَنْ يَكنّ له المسلمون - على اختلاف ميولهم وتوجّهاتهم - الاحترام أو التقديس.
وتقييم جمهور الناس لخروج الخارج تابع لتقييمهم لشخصه، ولِما يقتنعون به من مبادئه وأهدافه وسلوكه، ولا يكون الخروج على الحاكم بنفسه جريمة بنظر عموم المسلمين حسب مرتكزاتهم كما هو الحال عند الشارع الأقدس في
____________________
١ - تقدّم في/٢٥٤ وما بعدها.
الخروج على الإمام الشرعي؛ حيث يكون الخارج عليه باغياً يجب على المسلمين قتاله حتى يفيء لطاعته ويلزم جماعته.
غاية الأمر أنّ الخليفة نفسه حيث يفترض شرعية سلطته، فهو ومرتزقته يفترضون الخارجين عليه بغاة يعاملونهم معاملتهم، بل كثيراً ما يزيدون في التنكيل بهم على حكم البغاة تعدّياً وطغياناً.
إلاّ إنّ ذلك يفقد المصداقية عند جمهور المسلمين وعامّتهم، فلا يعترفون للخليفة بذلك، بل يرون هدفه الدفاع عن سلطته، وإشباع شهوته في الحكم والسلطة والاستغلال والاستئثار.
غاية الأمر أنّهم يستسلمون أخيراً للغالب بغض النظر عن شرعيته؛ اعترافاً بالأمر الواقع كما هو الحال في صراع الملوك فيما بينهم.
صارت الإمامة عند الجمهور دنيوية لا دينية
الثاني : إنّ الخلافة والإمامة في الصدر الأوّل كانت دينية ودنيوية، فكما يكون الخليفة مرجعاً للمسلمين في أمور دنياهم وسياسة أمورهم يكون مرجعاً لهم في دينهم.
وهو وإن كان قد يسأل غيره، ويستعين برأيه، إلّا أنّ له القول الفصل فيه. وتقدم عن ابن مسعود أنّه قال: إنّما نقضي بقضاء أئمّتنا(١) .
وعن سعيد بن جبير قال: «كنت أسأل ابن عمر في صحيفة ولو علم بها كانت الفيصل بيني وبينه. قال: فسألته عن الإيلاء. فقال: أتريد أن تقول: قال ابن عمر، وقال ابن عمر. قال: قلت: نعم، ونرضى بقولك ونقنع. قال: يقول
____________________
١ - المحلّى ٩/٢٨٣، ٢٨٦، الإيضاح/٣٤١.
في ذلك الأمراء»(١) .
وعن مطر قال: «ما لقيت شامياً أفقه من رجاء بن حياة إلا أنه إذا حركته وجدته شامياً وربما جرى الشيء فنقول [فيقول.ظ]: فعل عبد الملك بن مروان رحمة الله»(٢) .
وعن هشام بن عروة قال: «ما رأيت عروة يسأل عن شيء قط فقال فيه برأيه، إن كان عنده فيه علم قال بعلمه، وإن لم يكن عنده فيه علم قال: هذا من خالص السلطان»(٣) .
ولا يتوجّه الجمهور للسؤال من غيره والأخذ منه إلّا في حدود ما يسمح به. كما يظهر بأدنى ملاحظة لتاريخ الإسلام في الصدر الأول، وتقدم ويأتي بعض مفردات ذلك.
أمّا بعد أن سقطت قدسية الخلافة - نتيجة العوامل المتقدّمة - فقد اقتصرت الخلافة أخيراً عند الجمهور على الأمور الدنيوية وسياسة الدولة، تدعمها في ذلك القوّة والبطش بلا ضوابط من دون أن يكون الخليفة مرجعاً في أمور الدين.
واضطر الجمهور نتيجة ذلك للالتزام بعدم تشريع إمامة الدين في الإسلام - على خلاف ما عليه الشيعة - وأنّ على الناس أن يرجعوا للفقهاء على
____________________
(١) الطبقات الكبرى ج: ٦ ص: ٢٥٨ في ترجمة سعيد بن جبير. وقريب منه في مصنف ابن أبي شيبة ج: ٤ ص: ٩٨ كتاب الطلاق: في المولي يوقف وتفسير الطبري ج: ٢ ص: ٥٩١.
(٢) تاريخ دمشق ج: ١٨ ص: ١٠٤ في ترجمة رجاء بن حيوية، واللفظ له. تهذيب الكمال ج: ٩ ص: ١٥٤ في ترجمة رجاء بن حياة. تهذيب التهذيب ج: ٣ ص: ٢٢٩ في ترجمة رجاء بن حياة. طبقات الفقهاء ج: ١ ص: ٧٥ في ترجمة رجاء بن حياة الكندي. وغيرها من المصادر.
(٣) تاريخ دمشق ج: ٤٠ ص: ٢٥٧ في ترجمة عروة بن الزبير، واللفظ له. جامع بيان العلم وفضله ج: ٢ ص: ١٤٣.
اختلافهم، وأنّ الله (عزّ وجلّ) لم يجعل لهم علماً يعصمهم من الاختلاف.
بل قد يصل الأمر بهم إلى الالتزام بصواب الكلّ على اختلافهم، وأنّ الحقّ يتعدّد في مورد الخلاف بعدد آراء المجتهدين، وأنّ اختلافهم رحمة للأُمّة؛ لأنّ فيه سعة له.
ومهما يكن في ذلك من التخبّط فهو فتح عظيم للدين؛ حيث حرّره من تحكّم الخليفة غير المعصوم فيه، ومسخِه له كما حصل نظيره في الأديان السابقة.
كسر طوق الضغط الثقافي في الفترة الانتقالية
الجهة الثانية: كسر طوق الضغط الثقافي على المسلمين، وارتفاع الحجر عملياً عن الحديث النبوي الشريف، فأصحرت كلّ فئة بمفاهيمها التي تتبنّاها وثقافتها التي تحملها، وأخذت تحاول تعميم تلك المفاهيم والثقافة على المسلمين، وبدأت اات المختلفة تتضح، وتتميّز بعضها عن بعض في المجتمع الإسلامي.
مكسب التشيّع نتيجة كسر طوق الضغط الثقافي
وكان لشيعة أهل البيت (صلوات الله عليهم) الدور الأكبر في ذلك.
أوّلاً : لِما يأتي - في المطلب الثاني - من أنّ نهضة الإمام الحسين (صلوات الله عليه) شيعية الاتجاه.
وثانياً : لأنّ الإمام الحسين (صلوات الله عليه) نفسه - الذي هو الرجل الأوّل عند عموم المسلمين، والذي ضحى هذه التضحية الكبرى - هو الإمام الثالث للشيعة.
حيث يترتّب على هذين الأمرين أن يكون ردّ الفعل على العدوان الذي
حصل هو نشر الثقافة الشيعية من أجل الإنكار على العدوان المذكور، وبيان بشاعته.
وثالثاً : لأصالة المفاهيم الشيعية وعقلانيتها، وارتفاع مستوى ثقافة الشيعة، تبعاً لرفعة مقام أئمّتهم (صلوات الله عليهم) الذين هم ورثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأبواب مدينة علمه.
ورابعاً : لكثرة ما تضمّنه الكتاب المجيد والسُنّة النبوية الشريفة ممّا يخدم دعوة التشيّع، وعلم الله تعالى كم ظهر في هذه الفترة من الأحاديث التي تؤيّد الدعوة المذكورة من بقية الصحابة ومن التابعين، خصوصاً بعد مؤتمر الإمام الحسين (عليه السّلام) الذي سبق أنّه قد عقده في الحج لحفظ ونشر التراث الذي يخص أهل البيت (عليهم السّلام)، ويتضمّن رفعة مقامهم(١) .
وخامساً : لوجود القيادة الحكيمة المعصومة الراعية للشيعة ولدعوتهم، وتسديدها ودعمها بالمدّ الإلهي غير المحدود.
ولذا كتب لدعوة التشيّع البقاء والخلود والظهور والانتشار من بين جميع الدعوات التي ظهرت في مواجهة انحراف السلطة، رغم كلّ المعوّقات والألغام التي زُرعت في طريقها على طول التاريخ.
وبعد أن انتهى الحديث عن هذه الفترة الانتقالية وثمراتها المهمّة نقول:
التوجّه الديني في المجتمع الإسلامي نتيجة فاجعة الطفّ
من الطبيعي أن يكون لفاجعة الطفّ بأبعادها السابقة وتداعياتها السريعة أثرها العميق في المسلمين بحيث أدّت إلى يقظة كثير منهم، ورجوعهم لدينهم، واهتمامهم بالتعرّف عليه وتحمّل ثقافته؛ لعدّة عوامل أفرزتها واقعة الطفّ
____________________
١ - تقدّم تفصيله ومصدره في/١٠٧.
وتداعياتها السابقة:
أوّلها : الشعور بتدهور المجتمع الإسلامي، وابتعاده عن الدين وتقصيره في أمره بنحو يستوجب تأنيب الضمير على ذلك.
خصوصاً بعد أن ركّز أهل البيت (صلوات الله عليهم) وشيعتهم على عظم الجريمة، واهتمّوا بإحيائها والتذكير بها؛ بإقامة المآتم، وزيارة قبر الإمام الحسين (صلوات الله عليه)، ورثائه وما يجري مجرى ذلك.
حيث يكون ردّ الفعل المناسب لذلك من كثير ممّن لهم جذور دينية هو ترك السلطة ومَنْ يتنازع عليها جانباً والرجوع للدين، والتعرّف عليه، والتمسّك به.
ثانيها : معاناة الناس من السلطة الجائرة، ومن تدهور الأوضاع؛ نتيجة الصراعات والفوضى، فإنّ ردّ الفعل المناسب لذلك والميسور لعامّة الناس - ممّن لا حول له ولا قوّة - هو الانكفاء على النفس، والبُعد عن الفتن، واللجأ إلى الله (عزّ وجلّ) وطلب رضاه بالرجوع لدينه، والتزام تعاليمه الشريفة.
ولاسيما بعد أن ظهر على السلطة الاستهتار بالدين والاستهانة به؛ فإنّ ذلك يؤكّد الاندفاع نحو الدين؛ لكونه مظهراً إرادياً، أو لا إرادياً للتحدّي العملي للسلطة، والاحتجاج الصامت عليها الذي فيه السلامة من خطر الاحتكاك بها، مع ما فيه من فضح السلطة، والتنبيه لسلبياتها.
ولعلّ لهذين الأمرين أعظم الأثر في الصحوة الدينية التي تعيشها المجتمعات الإسلامية في أيامنا هذه بعد موجة التحلّل من الدين؛ تبعاً للغرب والشرق الماديين، ثمّ ظهور العدوان منهما والتجاوز على حقوق الشعوب.
ثالثها : قوّة التشيّع وانتشاره بعد فاجعة الطفّ حيث إنّ من أبرز مفاهيم
التشيّع وتعاليمه ضمّ العمل للعقيدة؛ فقد استفاض عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة من أهل بيته (صلوات الله عليهم) أنّ الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان(١) ، وأكّدوا (صلوات الله عليهم) على العمل كثيراً.
وكان التديّن والالتزام بالأحكام الشرعية من السمات البارزة في الشيعة، وقد سبق عن سفيان الثوري قوله: وهل أدركت خير الناس إلّا الشيعة؟ وسبق عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر (صلوات الله عليه) ما يُناسب ذلك(٢) .
وذلك ينضمّ للعاملين السابقين في تنبيه عامّة المسلمين لدينهم، وتحفيزهم على العمل بأحكامه، والتعرّف عليها وعلى واقع دينهم في العقائد والفقه والسلوك والأخلاق.
حاجة المجتمع الإسلامي لمتخصصين في الثقافة الدينية
وحيث تحرّر الدين وخرج عن هيمنة السلطة؛ لسقوط شرعية الدولة، نتيجة العوامل السابقة، فمن الطبيعي أن يحقّق التوجّه الديني المذكور الحاجة لجمهور المسلمين - على اختلاف توجّهاتهم - إلى جماعة يتوجّهون للثقافة الدينية، ويتخصّصون فيه، ويعرّفون به.
وهذه الطبقة قد كان لها وجود قبل ذلك من بقايا الصحابة والتابعين،
____________________
١ - نهج البلاغة ٤/٥٠، الخصال/١٧٨ ح ٢٣٩، وص ١٧٩ ح ٢٤١، عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) ٢/٢٠٤، سنن ابن ماجة باب في الإيمان، المعجم الأوسط ٦/٢٢٦، و٨/٢٦٢، تفسير القرطبي ١/٣٧٢، الدرّ المنثور ٦/١٠٠، تاريخ بغداد ١/٢٧١ في ترجمة محمد بن إسحاق بن محمد بن عبد الله، تهذيب الكمال ١٨/٨٢ في ترجمة عبد السّلام بن صالح، سير أعلام النبلاء ١٥/٤٠٠ في ترجمة علي بن حمشاذ، وغيرها من المصادر الكثيرة.
٢ - تقدّمت مصادره في/٣٥٨.
خصوصاً من أصحاب أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)، إلّا إنّها كانت محاصرة ومعزولة عن المجتمع العام؛ نتيجة الحجر الثقافي الذي قوي في عهد معاوية، ولعدم حاجة المجتمع لها، وعدم تبنّيه لها بعد مرجعية السلطة في الدين، ومن ثمّ كانت معرّضة للاضمحلال لو استمرت تلك المرجعية.
أمّا بعد سقوط شرعية السلطة، وفصل الدين عنها فقد قويت هذه الطبقة تدريجاً؛ نتيجة حاجة المجتمع إليها، وتعلّقهم بها، وتبنّيهم لها، وصار لها وجودها المتميّز على اختلاف توجّهاتها من حملة الحديث الشريف، والفقهاء، ومفسري القرآن المجيد، والزهّاد، والمتألهين، والوعّاظ ونحوهم ممّنْ يتميّز بجانب من جوانب الدين، ويكون مرجعاً أو قدوة فيه.
أهمية دور رجال الشيعة في مجال التخصص الديني
وقد كان لشيعة أهل البيت (عليهم السّلام) الحظّ الأوفر من ذلك؛ لثقافتهم العالية الأصيلة التي فتح الباب لها أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) وتعاهدها الأئمّة من ولده (عليهم السّلام)، ولصدق لهجتهم في الحديث وثقة الناس بهم.
وقد فرضوا أنفسهم بذلك على عموم المسلمين حتى ذكر الذهبي - مع ما هو عليه من التحامل على الشيعة - أنّه لو ردّ حديث الشيعة لذهبت جملة من الآثار النبوية(١) .
وقال الجوزجاني - على نصبه -: وكان قوم من أهل الكوفة لا يحمد الناس مذاهبهم هم رؤوس محدّثي الكوفة...، احتملهم الناس على صدق ألسنتهم في الحديث...(٢) ... إلى غير ذلك.
____________________
١ - ميزان الاعتدال ١/٥ في ترجمة أبان بن تغلب.
٢ - أحوال الرجال/٧٨ - ٨٠ في ترجمة فائد أبي الورقاء، واللفظ له، تاريخ دمشق ٤٦/٢٣٣ في ترجمة عمرو بن عبد الله بن أبي شعيرة، ميزان الاعتدال ٢/٦٦ في ترجمة زبيد بن الحارث اليامي، وقال الذهبي: وقال أبو إسحاق الجوزجاني - كعوائده في فظاظة عبارته - كان من أهل الكوفة...، =
عدم اقتصار الأمر على الشيعة
غير أنّ ذلك لا يعني اقتصار الأمر على الشيعة؛ فقد عمّ ذلك جميع المسلمين على اختلاف توجّهاتهم كما هو ظاهر بأدنى ملاحظة لتاريخ تلك الفترة، بل قد يكون ظهور ذلك في الشيعة محفّزاً لغيرهم على التوجّه في هذه الوجهة، ولو من أجل أن لا ينفرد الشيعة في الساحة، ويستقطبوا طلاب العلم والثقافة الدينية، فتفرض ثقافتهم على جميع المسلمين.
ظهور طبقة الفقهاء والمحدّثين
والحاصل: إنّ جمهور المسلمين على اختلاف توجّهاتهم ومشاربهم بدؤوا يرجعون في دينهم لفقهائهم، فظهر الفقهاء السبعة في المدينة المنوّرة، وظهر غيرهم في بقيّة أمصار المسلمين، وصار للحديث والفقه سوق رائج.
وأخذوا يتسابقون في ذلك؛ إمّا اهتماماً بمعرفة الحقيقة، أو لدعم الوجهة التي يتوجّه إليها الفقيه والمحدّث ويتعصّب لها، أو ليَبدو تفوّقه ويكون رأساً يرجع إليه الناس في دينهم... إلى غير ذلك من العوامل المختلفة.
الاتفاق على انحصار مرجعية الدين بالكتاب والسُنّة
ولهذا الأمر - على سلبياته الكثيرة - أهميته العظمى في ظهور معالم الدين، وقيام الحجّة عليه حيث كانت نتيجة ذلك الاتفاق على انحصار المرجعية في الدين بالكتاب المجيد والسُنّة الشريفة من دون أن تكون للسلطة، أو غيرها حق التدخّل فيه.
____________________
= تهذيب التهذيب ٨/٥٩ في ترجمة عمرو بن عبد الله بن عبيد، وغيرها من المصادر.
وحتى لو رجعوا في الدين لغير الكتاب والسُنّة - كالإجماع، وعمل أهل المدينة، والقياس، وغيرها - فإنّهم حاولوا بعد ذلك توجيه العمل عليها بالكتاب والسُنّة؛ لدعوى دلالة الكتاب والسُنّة على حجّية الأمور المذكورة، أو كشف تلك الأمور عن دلالة الكتاب والسُنّة على ما يطابقها.
وأخذوا تدريجاً بتثبيت الضوابط لذلك حتى تبلور الفقه عن طريق الفقهاء - على اختلاف مشاربهم وتوجّهاتهم - من دون دخل مباشر للسلطة.
تعامل السلطة مع الواقع الجديد بتنسيق وحذر
وقد فُرض هذا الأمر أخيراً في الواقع الإسلامي؛ نتيجة لما سبق حتى اضطرت السلطة لغض النظر عنه، بل للاعتراف به.
وقد حاولت التعامل معه بنحو من التنسيق والحذر يخفّف من وقعه عليها، وتناقضه معها، وذلك بأمرين:
إقدام السلطة على تدوين السُنّة
الأوّل : الاهتمام بتدوين السُنّة ولو بالنحو الذي يعجبها - على خلاف ما كان عليه الأوّلون - في محاولة منها للسيطرة على مسيرة الحديث والفقه.
فقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن محمد بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو سُنّة ماضية، أو حديث عمرة فاكتبه؛ فإنّي خشيت دروس العلم وذهاب أهله(١) .
____________________
١ - الطبقات الكبرى ٨/٤٨٠ في ترجمة عمرة بنت عبد الرحمن، واللفظ له، وج ٢/٣٨٧ عند ذكر عمرة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير، معرفة السنن والآثار ٦/٣٨٩، التمهيد - لابن عبد البر ١٧/٢٥١، الأعلام - للزركلي ٥/٧٢، تقييد العلم ١/٢٥٢ ح ٢١٨ الرواية عن الطبقة الثانية والثالثة من التابعين في ذلك، المعرفة والتاريخ ١/٤٤١، وغيرها من المصادر.
وعن الزهري: أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن، فكتبناها دفتراً دفتراً، فبعث إلى كلّ أرض له عليها سلطان دفتراً(١) .
تبنّي الخلفاء لبعض الفقهاء لكسب الشرعية منهم
الثاني: تبنّي الخلفاء لبعض الفقهاء جيلاً بعد جيل ودعمهم؛ من أجل تحسين صورتهم أمام الجمهور في محاولة لإثبات شرعية سلطتهم وتصرّفاتهم، وتسيير الفقه والحديث لصالحهم بعد فرض الدين في الواقع الإسلامي، وتحرّره من هيمنة السلطة.
مكسب الدين نتيجة هذين الأمرين
وباب الخطأ والتلاعب من المحدّثين والفقهاء وإن كان مفتوحاً، خصوصاً من أجل إرضاء السلطة كما يظهر بمراجعة التاريخ، إلّا أنّ لهذين الأمرين أهمّيتهما في صالح الدين؛ لأنّهما يتضمّنان الاعتراف ضمناً بمرجعية الكتاب المجيد والسُنّة الشريفة، وأنّه لا مجال لتحكّم الخليفة، أو غيره في الدين بالمباشرة.
غاية الأمر أنّه قد يستعين بالفقهاء والمحدّثين الذين يتبنّاهم، أو ينسّق معهم لتحقيق هدفه، بل قد يشتدّ ويقسو في فرض ما يريد والمنع من مخالفته.
إلا إنّ ذلك لا يضيع معالم الحقّ بعد أن تسالم الجميع على أنّ المرجع في الدين هو الكتاب المجيد المحفوظ بين الدفتين المنتشر بين المسلمين، والسُنّة الشريفة المحفوظة في الصدور والمسطورة في الزبر.
____________________
١ - جامع بيان العلم وفضله ١/٧٦.
موقف مالك بن أنس صاحب المذهب
ويبدو أنّ مالك بن أنس صاحب المذهب قد أدرك ذلك، فعن محمد بن عمر: سمعت مالك بن أنس يقول: لما حجّ المنصور دعاني فدخلت عليه فحادثته، وسألني فأجبته. فقال: عزمت أن آمر بكتبك هذه - يعني الموطأ - فتُنسخ نسَخاً، ثمّ أبعث إلى كلّ مصر من أمصار المسلمين بنسخة، وآمرهم أن يعملوا بما فيه، ويدعوا ما سوى ذلك من العلم المحدّث؛ فإنّي رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمهم.
قلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل؛ فإنّ الناس قد سيقت لهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كلّ قوم بما سيق إليهم، وعملوا به ودانوا به، من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، وإنّ ردّهم عمّا اعتقدوه شديد؛ فدع الناس وما هم عليه، وما اختار كلّ بلد لأنفسهم. فقال: لعمري، لو طاوعتني لأمرت بذلك(١) .
وعن ابن مسكين ومحمد بن مسلمة قالا: سمعنا مالكاً يذكر دخوله على المنصور، وقوله في انتساخ كتبه وحمل الناس عليه، فقلت: قد رسخ في قلوب أهل كلّ بلد ما اعتقدوه وعملوا به، وردّ العامّة عن مثل هذا عسير(٢) .
وروي أنّ هارون الرشيد أراد من مالك الذهاب معه إلى العراق، وأن يحمل الناس على الموطأ كما حمل عثمان الناس على القرآن، فقال له مالك: أمّا
____________________
١ - سير أعلام النبلاء ٨/٧٨ - ٧٩ في ترجمة مالك الإمام، واللفظ له، جامع بيان العلم وفضله ١/١٣٢، الانتقاء من فضائل الثلاثة الأئمّة الفقهاء/٤١، المنتخب من ذيل المذيل/١٤٤ القول في تاريخ التابعين والخالفين والسلف الماضين من العلماء ونقلة الآثار، ذكر مَنْ هلك منهم في سنة ١٦١ من الهجرة.
٢ - سير أعلام النبلاء ٨/٧٩ في ترجمة مالك الإمام، واللفظ له، الانتقاء من فضائل الثلاثة الأئمّة الفقهاء/٤١.
حمل الناس على الموطأ فلا سبيل إليه؛ لأنّ الصحابة (رضي الله تعالى عنهم) افترقوا بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم في الأمصار، فعند كلّ أهل مصر علم، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «اختلاف أُمّتي رحمة»(١) .
على أنّ التلاعب والخطأ محدودان نسبياً؛ نتيجة الصراع بين الفقهاء والمحدّثين، واختلاف الأنظار والمصالح حيث يحاسب المخطئ والمتلاعب من قبل الآخرين على ضوء الكتاب والسُنّة، ويكون هدفاً لإنكارهم وتشنيعهم.
ولو فرض أن شذّ بعضهم في اختلاق الحديث، أو في آرائه الفقهية، بعيداً عمّا هو المألوف كان معزولاً عن الكيان العام، ولا احترام لرأيه.
كما إنّه ربما يكون انتساب الفقيه، أو المحدّث للسلطة نقطة ضعف فيه تقلّل من احترام رأيه وحديثه، وتكون مثاراً للإنكار عليه؛ لِما سبق من وهن شرعية السلطة، وتشوّه صورتها عند جمهور المسلمين.
قوّة الكيان الشيعي نتيجة ما سبق
وقد ساعد على ذلك كثيراً قيام كيان معتدٍّ به لشيعة أهل البيت (صلوات الله عليهم)؛ حيث يهتمّون - بتوجيه من أئمّتهم (صلوات الله عليهم) - بالحق ويدعون له، وينكرون على الظالمين والمنحرفين، ويتتبعون سقطاتهم، ويشنّعون عليهم... إلى غير ذلك ممّا يكبح جماح الانحراف، وإن تحمّلوا في سبيل ذلك ضروب المحن والمصائب.
____________________
١ - فيض القدير ١/٢٧١، واللفظ له، حياة الحيوان الكبرى ٢/٥٧١ باب الميم، في مطية، آداب العلماء والمتعلمين ١/٢ الفصل الأوّل، آداب العالم في علمه، النوع الثالث، وقد روي أنّ ذلك كان مع المأمون كما في تاريخ دمشق ٣٢/٣٥٦ في ترجمة عبد الله بن محمد، وحلية الأولياء ٦/٣٦١ - ٣٦٢ في ترجمة مالك بن أنس.
تحوّل مسار الثقافة الدينية بعد الفترة الانتقالية
والمتحصّل من جميع ما سبق: إنّه يبدو التحوّل واضحاً في مسار الثقافة الدينية على الصعيد العام بالمقارنة بين ما كان الوضع عليه من الصدر الأوّل حتى موت معاوية، وما صارت الأمور إليه بعد الفترة الانتقالية واستيلاء المروانيين على السلطة.
وبذلك بقيت معالم الدين، وكيانه العام، واتفق المسلمون على مشتركات كثيرة تحفظ صورة الدين ووحدته، وأهمّها انحصار المرجعية بالكتاب المجيد، والسُنّة الشريفة.
عقدة احترام سُنّة الشيخين
نعم، بقي أمر مرجعية سيرة الشيخين والأخذ بسنّتهما، الذي بدا بصورة رسمية في الشورى عند بيعة عثمان. وربما كانت الأرضية له قد سبقت ذلك.
فعن عبد الله بن عمر أنه قال: «قيل لعمر: ألا تستخلف؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأثنوا عليه. فقال: راغب وراهب. وددت أني نجوت منها كفافاً، لا لي ولا عليّ. لا أتحملها حياً وميتاً»(١).
فإنه كالصريح في ان عمل أبي بكر سنّة تصلح لأن تتبع، كسنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن الوظيفة مع اختلافهما التخيير بينهما، ولا يتعين الأخذ بسنّة
____________________
(١) صحيح البخاري ج: ٨ ص: ١٢٦ كتاب الأحكام: باب الاستخلاف، واللفظ له. صحيح مسلم ج: ٦ ص: ٤-٥ كتاب الأمارة: باب الاستخلاف وتركه. مسند أحمد ج: ١ ص: ٤٣ مسند عمر بن الخطاب. السنن الكبرى للبيهقي ج: ٨ ص: ١٤٨ كتاب قتال أهل البغي: جماع أبواب الرعاة: باب الاستخلاف. سنن الترمذي ج: ٣ ص: ٣٤١ أبواب الفتن: باب ما جاء في الخلافة. وغيرها من المصادر الكثيرة جداً.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وكيف كان فنظراً لاحترام الجمهور لهما احتراماً يبلغ حدّ التقديس، نتيجة العوامل المتقدّمة حاول كثير منهم أن يقرّوا ما صدر عنهما من التشريعات، ويجعلوا سنّتهما ماضية بنفسها - من دون نظر لموافقتها للكتاب المجيد والسُنّة الشريفة - بحيث لا يحق لأحد الخروج عنها، كما سبق في حديث أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسّلام)(١) .
وقد بقي ذلك بعده (عليه السّلام) مع شدّة النكير عليه منه ومن الأئمّة من ذريته (صلوات الله عليهم) ومن شيعتهم، وبعض مَنْ اقتنع بوجهة نظرهم.
حتى ورد في الحديث عن ابن عباس: قال: تمتّع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: ما يقول عرية؟! قال: يقول: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون؛ أقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول: نهى أبو بكر وعمر(٢) .
وفي حديث آخر أنّه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؛ أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر(٣) .
وفي حديث ثالث له: والله ما أراكم منتهين حتى يعذّبكم الله، نحدّثكم
____________________
١ - تقدّم في/٢٧٥ وما بعده.
٢ - مسند أحمد ١/٣٣٧ مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، واللفظ له، جامع بيان العلم وفضله ٢/١٩٦، تذكرة الحفاظ ٣/٨٣٧ في ترجمة محمد بن عبد الملك بن أيمن، سير أعلام النبلاء ١٥/٢٤٣ في ترجمة ابن أيمن، المغني - لابن قدامة ٣/٢٣٩، الشرح الكبير - لابن قدامة ٣/٢٣٩، الفقيه والمتفقه ١/٣٧٧، حجّة الوداع ١/٣٩٨ ح ٣٦٩ الباب الرابع والعشرون الأحاديث الواردة في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفسخ الحجّ بعمرة في حجّة الوداع... وغيرها من المصادر.
٣ - كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد/١٤٩، واللفظ له، زاد المعاد ٢/١٧٨ أعذار مَنْ لم يأخذ بفسخ الحجّ إلى العمرة، أضواء البيان ٧/٣٢٨، النصائح الكافية/٢١٣، وغيرها من المصادر.
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتحدّثونا عن أبي بكر وعمر...(١) .
وقال أيضاً: أما تخافون أن يخسف الله بكم الأرض؟! أقول لكم: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟!...(٢) .
وعن ابن عمر أنّه كان يأتي بمتعة الحجّ، فيُقال له: إنّ أباك كان ينهى عنها؟ فيقول: لقد خشيت أن يقع عليكم حجارة من السماء، قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أفسُنّة رسول الله تُتبع، أم سُنّة عمر بن الخطاب؟!(٣) .
وفي صحيح زرارة: جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر (عليه السّلام) فقال له: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: «أحلّها الله في كتابه وعلى لسان نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم، فهي حلال إلى يوم القيامة». فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرّمها عمر، ونهى عنها؟! فقال: «وإن كان فعل». قال: إنّي أُعيذك بالله من ذلك، أن تحلّ شيئاً حرّمه عمر. قال: فقال له: «فأنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهلمّ أُلاعنك أنّ القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنّ الباطل ما قال صاحبك...»(٤) .
وفي حديث أبي بصير: قال أبو عبد الله (عليه السّلام): «يا أبا محمد، كان عندي رهط من أهل البصرة فسألوني عن الحجّ، فأخبرتهم بما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبما أمر به. فقالوا لي: إنّ عمر قد أفرد الحجّ. فقلت لهم: إنّ هذا رأي رآه عمر، وليس رأي عمر كما صنع رسول الله صلّى الله عليه وآله»(٥) ... إلى غير ذلك.
____________________
١ - جامع بيان العلم وفضله ٢/١٩٦، واللفظ له، التمهيد - لابن عبد البر ٨/٢٠٨، أضواء البيان ٤/٣٥٢، إمتاع الأسماع ٩/٣١ فصل في ذكر حجّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وغيرها من المصادر.
٢ - الإحكام - لابن حزم ٢/١٤٨، و٤/٥٨١، و٥/٦٥٠.
٣ - البداية والنهاية ٥/١٥٩ في فصل لم يسمه بعد ذكر حجّة من ذهب إلى أنّه (عليه السّلام) كان قارناً، وقريب منه في مسند أحمد ٢/٩٥ في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب.
٤ - الكافي ٥/٤٤٩ من أبواب المتعة ح ٤.
٥ - وسائل الشيعة ٨/١٧٣ باب ٣ من أبواب أقسام الحج ح ٦.
وقد حاول الجمهور والسلطة الجري على ذلك حتى بعد تدوين السُنّة، وظهور طبقة الفقهاء والمحدّثين كما يظهر ممّا تقدّم من حديث عروة بن الزبير المعدود من فقهاء المدينة السبعة، وحديث عبد الله بن عمير الليثي مع الإمام أبي جعفر الباقر (صلوات الله عليه).
موقف عمر بن عبد العزيز
وقد سبق في كتاب عمر بن عبد العزيز الأمر بكتابة السُنّة الماضية(١) .
والظاهر أنّ المراد بها ما يعمّ سُنّة الشيخين كما يناسبه قوله في خطبة له في خلافته: ألا إنّ ما سنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحباه فهو دين نأخذ به وننتهي إليه، وما سنّ سواهما فإنّا نرجئه(٢) .
وهو بذلك يجري على ما جرى عليه عبد الرحمن بن عوف حين أخذ اتّباع سيرتهما شرطاً في بيعة الخليفة، كالعمل بكتاب الله تعالى وسُنّة نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم، وما جرى عليه عثمان لما أتمّ الصلاة بمنى، حيث ورد أنّه خطب فقال: إنّ السُنّة سُنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسُنّة صاحبيه. ولكنّه حدث العام من الناس فخفت أن يستنّوا(٣) .
بل في كلام لعمر بن عبد العزيز آخر: سنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وولاة الأمر من بعده سنناً الأخذ بها تصديق بكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوّة على
____________________
١ - تقدّم في/٣٩٤.
٢ - تاريخ دمشق ١١/٣٨٥ في ترجمة حاجب بن خليفة، واللفظ له، كنز العمال ١/٣٧٠ ح ١٦٢٤، تاريخ الخلفاء/٢٤١ في ترجمة عمر بن عبد العزيز (رضي الله عنه).
٣ - السنن الكبرى - للبيهقي ٣/١٤٤ كتاب الصلاة، جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في السفر، باب مَنْ ترك القصر في السفر غير رغبة عن السُنّة، واللفظ له، معرفة السنن والآثار ٢/٤٢٩، كنز العمال ٨/٢٣٤ ح ٢٢٧٠١، تاريخ دمشق ٣٩/٢٥٥ في ترجمة عثمان بن عفان، وغيرها من المصادر.
دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر فيما خالفها. مَنْ اقتدى بها مهتدٍ، ومَنْ استنصر بها منصور، ومَنْ خالفها اتّبع غير سبيل المؤمنين، وولّاه الله ما تولّى، وصلاه جهنم وساءت مصيراً(١) . ومقتضاه إمضاء سُنّة عثمان أيضاً.
كما جرى على ذلك معاوية؛ فإنّه لما حجّ صلّى الظهر ركعتين، ولما دخل فسطاطه عتب عليه الأمويون؛ لأنّه خالف سُنّة عثمان فخرج فصلّى العصر أربعاً(٢) .
إلاّ إنّه يبدو شعور عمر بن عبد العزيز بعد ذلك بعدم إمكان فرض سُنّة عثمان على المسلمين؛ بسبب تحرّر فقههم من سيطرة السلطة، فتراجع عن ذلك وأرجأه - كما في خطبته السابقة - واقتصر على سُنّة الشيخين؛ لما لهما من المكانة في نفوس الجمهور.
التغلّب أخيراً على عقدة سيرة الشيخين
لكن يظهر اتضاح الضوابط في الفقه وجميع شؤون الدين بعد ذلك وتبلورها؛ نتيجة الإنكار على الظالمين وتعريتهم، والتأكيد من أئمّة أهل البيت (صلوات الله عليهم) ومن شيعتهم، بل من الجميع على انحصار المرجعية في الدين بالكتاب المجيد والسُنّة الشريفة، وعدم جواز الأخذ من غيرهما، وأنّ ذلك هو الابتداع المنهي عنه عقلاً وشرعاً.
وقد اضطر ذلك الجمهور أخيراً إلى التراجع عن الموقف المذكور من سُنّة الشيخين، والبناء على انحصار المرجعية في الدين بالكتاب والسُنّة، وأنّه لا بدّ أن
____________________
١ - تفسير ابن أبي حاتم ٤/١٠٦٧، واللفظ له، الدرّ المنثور ٢/٢٢٢، البداية والنهاية ٩/٢٤٢ أحداث سنة إحدى ومئة من الهجرة، جامع بيان العلم وفضله ٢/١٨٧، وغيرها من المصادر.
وقد نسب هذا الكلام إلى مالك أيضاً، كما في سير أعلام النبلاء ٨/٩٨ في ترجمة مالك الإمام.
٢ - تقدّمت مصادره في/٢٣٨.
يكون منهما الانطلاق لتحديد الأدلّة في أحكام الدين وشؤونه.
نعم، تحوّل الخلاف بعد ذلك إلى الخلاف في الضوابط والأدلّة التي يدلّ الكتاب المجيد والسُنّة الشريفة على حجّيتها في أمور الدين؛ ولذلك الأثر الكبير في اختلاف المسلمين، وظهور الفرق والمذاهب فيهم.
إلاّ إنّه ليس بتلك الأهمية بعد الاتفاق على انحصار المرجعية في الكتاب والسُنّة؛ لأنّ طالب الحقّ يبقى حرّاً في الاختيار على ضوء هذين المرجعين العظيمين. وهو كافٍ في قيام الحجّة على الدين الحقّ ووضوح معالمه، كما تكفّل الله (عزّ وجلّ) بذلك. ولا يضرّه بعد ذلك التكلّف والتعصّب ضدّ الحقّ وأهله.
موقف الجمهور أخيراً من سُنّة الشيخين
أمّا موقف الجمهور من سيرة الشيخين فقد انحصر بين أمرين:
الأوّل : ترك بعض سُنّنهم، كما حصل في متعة الحجّ التي حرمها عمر وغيره.
الثاني : دعوى دعم الكتاب أو السُنّة لما سنّاه، كما حصل في متعة النساء وغيره، في كلام طويل وتفاصيل كثيرة لا يهمّنا التعرّض له.
وهي ترجع إمّا لوجود روايات في ذلك تضمّنتها كتبهم، وإمّا لحسن الظنّ بهما وتنزيههما عن الابتداع في الدين، وأنّهما لا يرضيان بذلك، بل لا بدّ أن يكونا قد اطّلعا على دليل لم يصل إلينا.
فعن ابن حزم في التعقيب على ما تقدّم من كلام عروة بن الزبير مع ابن عباس: إنّها لعظيمة ما رضي بها قطّ أبو بكر وعمر (رضي الله عنهما)(١) .
وقال الذهبي في الدفاع عن عروة: قلت: ما قصد عروة معارضة
____________________
١ - تذكرة الحفاظ ٣/٨٣٧ في ترجمة محمد بن عبد الملك بن أيمن.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهم، بل رأى أنّهما ما نهيا عن المتعة إلّا وقد اطّلعا على ناسخ(١) .
وهذا منهم وإن ابتنى في كثير من الموارد على التمحّل غير المقبول، إلّا إنّه فتح عظيم للدين حيث يستبطن الاعتراف بانحصار المرجع فيه بالكتاب المجيد والسُنّة الشريفة، وبذلك تتمّ الحجّة، والتمحّل لا ينفع صاحبه، ولا يكون عذراً له مع الله (عزّ وجلّ). كما لا يقبله المنصف من الناس.
وبذلك اتّضحت معالم الدين، وتجلّت ضوابط الحقّ من الباطل بنحو يتيسّر لطالب الحقّ الوصول إليه؛ لظهور حجّته، ويكون حائلاً دون تحريف الدين وضياعه كما حصل في الأديان السابقة.
كلّ ذلك بجهود أئمّة أهل البيت (صلوات الله عليهم)، وفي قمّتها نهضة الإمام الحسين (عليه السّلام) التي انتهت بفاجعة الطفّ الدامية التي هزّت ضمير المسلمين، ونبّهتهم من غفلتهم، وغيّرت وجهتهم، وارتفعت بسببها أصوات الإنكار على الظالمين، وحفّزت على نقد مواقفهم وسلوكهم وتعريتهم بنحو قضى على مشروعهم في استغفال المسلمين، وتدويل الدين والتحكّم فيه، ممّا يؤدّي إلى ضياع معالمه على طالبيه.
فجزى الله الإمام الحسين (صلوات الله عليه) عن الإسلام والمسلمين خير جزاء المحسنين، والسّلام عليه وعلى المستشهدين معه ورحمة الله وبركاته.
____________________
١ - سير أعلام النبلاء ١٥/٢٤٣ في ترجمة ابن أيمن.
المطلب الثاني
فيما كسبه التشيّع
لأهل البيت (عليهم السّلام) بخصوصيته
ظهر ممّا سبق في المطلب الأوّل بعض مكاسب دعوة التشيّع لأهل البيت (صلوات الله عليهم) نتيجة فاجعة الطفّ.
كما يأتي في المقام الثاني من الفصل الثاني - عند الكلام في العِبَر التي تستخلص من فاجعة الطفّ - أنّها سهلت على الأئمّة من ذرية الحسين (صلوات الله عليهم) إقناع الشيعة بالصبر ومهادنة السلطة من أجل التفرّغ لبناء الكيان الشيعي الثقافي والعملي، وهو مكسب مهم جدّاً.
والمهم هنا التعرّض لمكاسب أُخرى لها أهمية كبرى في قيام كيان التشيّع وقوّته وبقائه، فنقول بعد الاستعانة بالله تعالى:
من الظاهر أنّ دعوة التشيّع تعتمد من يومها الأوّل:
أوّلاً : على الاستدلال والمنطق السليم والحجّة الواضحة كما ذكرناه آنفاً، ويظهر للناظر في محاورات الشيعة وحجاجهم مع الآخرين ممّا تناقلته الناس وسُطّر في الزبر.
وثانياً : على العاطفة؛ لِما لأهل البيت (صلوات الله عليهم) من مكانة سامية في نفوس عامّة المسلمين، وكثير من غيرهم، ولِما وقع عليهم (عليهم السّلام) من الظلم والأذى، وتجرّعوه من الغصص والمصائب. حيث يوجب ذلك بمجموعه
انشداد الناس لهم عاطفياً.
وثالثاً : على الإعلام والإعلان عن دعوة التشيّع ونشر ثقافته، وإظهار حججه، وإسماع صوته لأتباع الدعوة من أجل تثقيفهم وتعريفهم بدينهم، وللآخرين من أجل إقناعهم، وإقامة الحجّة عليهم.
وقد جاءت فاجعة الطفّ الدامية - بأبعادها المتقدّمة، وتداعياتها المتلاحقة -؛ لتدعم هذه الدعوة الشريفة في الجوانب الثلاثة.
وبيان ذلك يكون في مقامات ثلاثة:
المقام الأوّل
في مكسب التشيّع من حيثية الاستدلال
سبق في المطلب الأوّل أنّ فاجعة الطفّ قد هزّت ضمير المسلمين، ونبّهتهم من غفلتهم، وانتهت بهم إلى الالتزام بانحصار المرجعية في الدين بالكتاب المجيد والسُنّة الشريفة.
ومن الظاهر أنّ ذلك كما يكون مكسباً للإسلام بكيانه العام، كذلك هو مكسب جوهري للتشيّع بالمعنى الأخص، وهو الذي يبتني على أنّ الخلافة والإمامة بالنصّ، وأنّ الأئمّة اثنا عشر.
اعتماد التشيّع بالدرجة الأولى على الكتاب والسُنّة
وذلك لاعتماد التشيّع المذكور بالدرجة الأولى على الكتاب المجيد والسُنّة الشريفة، وخصوصاً السُنّة التي حاولت السلطة في الصدر الأوّل تغييبه، والتحجير عليه، والمنع من روايتها إلّا في حدود مصلحته كما سبق.
ومن الطريف جدّاً أنّ العناية الإلهية حفظت لهذا التشيّع ما يكفي في الاستدلال عليه والردّ على خصومه من الكتاب المجيد وأحاديث الجمهور ورواياتهم، ومن التاريخ الذي ثبتوه بأنفسهم بحيث لو تجرّد الباحث عن التراكمات والموروثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ونظر في تلك الأحاديث ووقائع التاريخ بموضوعية تامّة لاتضحت له معالم الحقّ، وبخع لدعوة التشيّع،
ولزم خطّ أهل البيت (صلوات الله عليهم).
وقد تقدّم في أوائل المقام الثاني عن الإمام الصادق (صلوات الله عليه) أنّ طالب الحقّ أسرع إلى هذا الأمر من الطير إلى وكره(١) .
وقد حاول أهل العلم من خصوم التشيّع تجاهل تلك الآيات والأحاديث، وعدم التركيز عليه، أو الجواب عنها بوجوه ظاهرة التكلّف والتعسّف بنحو لا يخفى على طالب الحقّ وعلى المنصف.
انحصار المرجعية في الدين بالكتاب والسُنّة انتصار للتشيّع
وعلى كلّ حال فقد اتّضحت معالم الدين، وكانت الغلبة منطقياً للتشيّع بعد أن تمّ تسالم المسلمين بعد فاجعة الطفّ، وما تبعها من تداعيات - كما سبق - على انحصار المرجع في الدين بالكتاب المجيد والسُنّة الشريفة، وأنّه لا يحق لأي شخص أن يخرج عنهما، أو يتحكّم في الدين من دون أن يرجع لهما، وأنّ الخروج عنهما جريمة تطعن في شخص الخارج مهما كان شأنه.
الطرق الملتوية التي سلكها خصوم التشيّع لتضييع هذا الانتصار
ولذا اضطر خصوم التشيّع على طول الخطّ وحتى يومنا الحاضر لمقاومته، والمنع من امتداده في عمق المجتمع المسلم بطرق:
أوّلها : القمع والتنكيل بالشيعة بمختلف الوجوه وبدون حدود؛ لئلا يتسنّى لهم إسماع دعوتهم، والاستدلال عليها.
ثانيها : تشويه صورتهم، وافتراء كثير من الأمور المستنكرة عليهم، بل كثيراً ما انتهى بهم الأمر إلى تكفير الشيعة وإخراجهم من الإسلام.
____________________
١ - تقدّم في/٣١٩.
كلّ ذلك من أجل تنفير عامّة الجمهور منهم، وإبعادهم عنهم؛ لئلا يتيسّر لهم السماع منهم، والتعرّف على ثقافتهم وعقيدتهم الحقيقية، وعلى أدلّتهم المنطقية عليه.
ثالثها : إبعاد عامّة الجمهور عن كثير من تراث الجمهور أنفسهم، وإغفالهم عمّا يخدم خطّ التشيّع منه، والتركيز على غيره وإشغالهم به، وإن كان دون ما سبق دلالة أو سنداً.
رابعها : محاولة إبعاد عامّة الجمهور أيضاً عن البحث في الأمور العقائدية، وحملهم على التمسّك بما عندهم على أنّها مسلمات لا تقبل البحث والنظر.
خامسها: إغفال التراث والفكر الشيعي في مقام البحث والنظر، وإبعادهما عن متناول الجمهور، بل حتى عن الباحثين منهم.
وقد بلغنا أنّ بعض المكتبات المهمّة في عصرنا تمتنع من عرض الكتب الشيعية وإن كانت قد تعرض كتباً تتضمّن أفكاراً تتناقض مع الدين والأخلاق.
وقد جروا في ذلك على سيرة أسلافهم.
قال ابن خلدون: وشذّ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها، وفقه انفردوا به، وبنوه على مذهبهم في تناول بعض الصحابة بالقدح، وعلى قولهم بعصمة الأئمّة، ورفع الخلاف عن أقوالهم، وهي كلّها أصول واهية، وشذّ بمثل ذلك الخوارج.
ولم يحتفل الجمهور بمذاهبهم، بل أوسعوها جانب الإنكار والقدح فلا نعرف شيئاً من مذاهبهم، ولا نروي كتبهم، ولا أثر لشيء منها إلّا في مواطنهم؛ فكتب الشيعة في بلادهم، وحيث كانت دولتهم قائمة...(١) .
بل موقفهم من الخوارج دون موقفهم من الشيعة؛ إذ كثيراً ما يتعاطفون
____________________
١ - مقدّمة ابن خلدون ١/٤٤٦ الفصل السابع في علم الفقه وما يتبعه من فرائض.
معهم، ويتواصلون مع رجالهم وتراثهم كما يظهر بالرجوع للمصادر المعنية بذلك.
ويلحق بذلك تجاهل أئمّة الشيعة (صلوات الله عليهم) وجميع رموز التشيّع وأعلامه، أو التخفيف من شأنهم مع ما لهم من الأثر الحميد في الإسلام، والموقع المتميز في المسلمين، وتسالمهم على رفعة مقامهم.
سادسها: التحذير من الاحتكاك بالشيعة والتحدّث معهم في الأمور العقائدية، وفتح باب الجدل والاحتجاج معهم... إلى غير ذلك ممّا يدلّ على شعور الجمهور بأصالة الفكر الشيعي وقوّة حجّته.
ولذا كان التشيّع في غنى عن نظير ذلك مع بقيّة فرق المسلمين، بل يؤكّد الشيعة على لزوم البحث والنظر في الدين بموضوعية كاملة، كما ينتشر تراث الجمهور بينهم على ما تعرّضنا له في جواب السؤال الأوّل من الجزء الأوّل من كتابنا (في رحاب العقيدة).
رفض الإمام الحسين (عليه السّلام) نظام الجمهور في الخلافة
وفي ختام الحديث عمّا كسبه التشيّع من فاجعة الطفّ من حيثية الاستدلال والبرهان يحسن التنبيه لأمر له أهميته في ذلك.
وهو إنّ الإمام الحسين (صلوات الله عليه) بما له من مقام رفيع عند جمهور المسلمين قد خرج على نظام الخلافة عند الجمهور.
وإذا كان الجمهور قد تجاهلوا تلكؤ أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسّلام) عن بيعة أبي بكر، بل إنكاره عليه، وحاولوا تكلّف توجيه موقفه (عليه السّلام) بما ينسجم مع شرعيتها وشرعية النظام المذكور.
وتجاهلوا أيضاً موقف الصديقة فاطمة الزهراء سيّدة النساء (صلوات الله عليه) حيث ماتت مهاجرة لأبي بكر، غير معترفة بخلافته مع ما هو المعلوم من
وجوب معرفة الإمام والبيعة له، وأنّ مَنْ مات ولم يعرف إمام زمانه ولم يبايعه ويقرّ له بالطاعة مات ميتة جاهلية.
فمن الظاهر أنّه لا يسعهم تجاهل موقف الإمام الحسين (صلوات الله عليه) من بيعة يزيد ورفضه لها وخروجه عليه، وإصراره على موقفه حتى انتهى الأمر بفاجعة الطفّ بأبعادها وتداعياتها السابقة.
وحينئذٍ يدور الأمر عقلياً بين الالتزام بعدم شرعية بيعة يزيد؛ لعدم شرعية النظام الذي ابتنت عليه، وهو السبق للبيعة ولو بالقوّة كما عليه الجمهور، ويرفضه الشيعة جملة وتفصيلاً، أو الالتزام بعدم شرعية خروج الإمام الحسين (صلوات الله عليه) وكونه باغياً، يجوز، بل يجب قتاله كما جرى عليه يزيد ومَنْ هو على خطّه من المغرقين في النصب.
وليس بعد هذين الوجهين إلّا الحيرة والتذبذب، أو الهرب من الحساب كما قد يبدو من عامّة الجمهور، وكفى بهذا مكسباً للتشيّع ببركة فاجعة الطفّ، ويأتي في المقام الثاني ما يتعلّق بذلك وينفع فيه.
المقام الثاني
في الجانب العاطفي
وقد خدمت واقعة الطفّ دعوة التشيّع في هذا الجانب من جهتين:
نهضة الإمام الحسين (عليه السّلام) شيعية الاتجاه
الجهة الأولى: إنّ الإمام الحسين (صلوات الله عليه) وإن رفع شعار الإصلاح في أُمّة الإسلام، إلّا إنّه رفعه بلواء التشيّع، فهو:
أوّلاً: يقول في وصيته لأخيه محمد بن الحنفية حينما أراد الخروج من المدينة: «... وإنّي لم أخرج أشرّاً ولا بطراً، ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في أُمّة جدّي صلى الله عليه وآله وسلم. أريد أن آمر بالمعروف، وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدّي وأبي علي بن أبي طالب...»(١) .
____________________
١ - العوالم/١٧٩، واللفظ له، بحار الأنوار ٤٤/٣٢٩ - ٣٣٠، مناقب آل أبي طالب - لابن شهرآشوب ٣/٢٤١ فصل في مقتله (عليه السّلام)، لكن ذكره على أنّه كلام للإمام الحسين (عليه السّلام) خاطب به محمد بن الحنفية وعبد الله بن عباس لما أشارا عليه بترك الخروج للعراق.
ومن الطريف أنّ ابن أعثم روى الكتاب هكذا:...أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدّي محمد، وسيرة أبي علي بن أبي طالب، وسيرة الخلفاء الراشدين.... الفتوح - لابن أعثم ٥/٢٣ ذكر وصية الحسين (رضي الله عنه) لأخيه محمد بن الحنفية (رضي الله عنه)، وتبعه في ذلك الخوارزمي في مقتله ١/١٨٩.
هذا ولا ينبغي الإشكال في كون هذه الزيادة موضوعة: =
____________________
= أوّلاً: لأنّ إطلاق عنوان (الخلفاء الراشدين) على الأوّلين لم يعرف في عصور الإسلام الأولى، وإنّما حدث بعد ذلك في عصر العباسيين.
وثانياً: لأنّ ذلك لا يتناسب مع رفض أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) لاشتراط عبد الرحمن بن عوف في بيعة الشورى الالتزام بسيرة أبي بكر وعمر.
وثالثاً: لأنّ ذلك لا يتناسب مع كون أنصار الإمام الحسين (صلوات الله عليه) الذين دعوه واستجاب لهم هم شيعته من أهل الكوفة، وموقفهم ممّن تقدّم على أمير المؤمنين (عليه السّلام) معلوم، ولاسيما عثمان حيث إنّ سيرته أثارتهم فيمَنْ ثار عليه.
وهذا حجر بن عدي من أعيان الشيعة في الكوفة ورد في شهادة الشهود في تجريمه: وزعم أنّ هذا الأمر لا يصلح إلّا في آل أبي طالب. الكامل في التاريخ ٣/٤٨٣ ذكر مقتل حجر بن عدي وعمرو بن الحمق وأصحابهما.
ولمّا قدم عبد الله بن مطيع الكوفة والياً من قبل عبد الله بن الزبير خطب الناس، فقال في جملة ما قال: وأمرني بجباية فيئكم، وأن لا أحمل فضل فيئكم عنكم إلّا برضى منكم، ووصية عمر بن الخطاب التي أوصى بها عند وفاته، وبسيرة عثمان بن عفان التي سار بها في المسلمين....
فقام إليه السائب بن مالك الأشعري، فقال: أما أمر ابن الزبير إيّاك أن لا تحمل فضل فيئنا عنّا إلّا برضانا فإنّا نشهدك أنّا لا نرضى... وأن لا يسار فينا إلّا بسيرة علي بن أبي طالب...، ولا حاجة لنا في سيرة عثمان في فيئنا، ولا في أنفسنا؛ فإنّها إنّما كانت أثرة وهوى، ولا في سيرة عمر بن الخطاب في فيئنا، وإن كانت أهون السيرتين علينا ضرّاً....
فقال يزيد بن أنس: صدق السائب بن مالك وبر. رأينا مثل رأيه وقولنا مثل قوله. تاريخ الطبري ٤/٤٩٠ أحداث سنة ست وستين من الهجرة، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/٢١٣ أحداث سنة ست وستين من الهجرة، ذكر وثوب المختار بالكوفة، ولكنّه بتر كلام يزيد بن أنس، البداية والنهاية ٨/٢٩٠ - ٢٩١ أحداث سنة ست وستين من الهجرة، ولكنّه أجمل الرواية مع بعض التصرّف فيه، نهاية الأرب في فنون الأدب ٢١/٦ - ٧ ذكر وثوب المختار في الكوفة، جمهرة خطب العرب ٢/٦٨ - ٦٩ خطبة عبد الله بن مطيع العدوي حين قدم الكوفة.
وقريب منه في الفتوح - لابن أعثم ٥/٢٤٩ ابتداء خروج المختار بن أبي عبيد وما كان منه، وأنساب الأشراف ٦/٣٨٣ في أمر المختار بن أبي عبيد الثقفي وقصصه، وغيرهما من المصادر. =
وهو (عليه السّلام) بذلك يشير إلى أنّ السيرة الرشيدة التي ينبغي اتّباعها والتمسّك بها هي سيرة النبي وأمير المؤمنين (صلوات الله عليهما وآلهما)، دون سيرة غيرهما ممَنْ استولى على السلطة.
____________________
= ورابعاً: لأنّ المعركة في الطفّ قد تضمّنت ما لا يناسب ذلك؛ ففي حديث عفيف بن زهير - وكان ممّنْ شهد المعركة - قال: وخرج يزيد بن معقل... فقال: يا برير بن خضير كيف ترى صنع الله بك؟
قال: صنع الله - والله - بي خيراً، وصنع الله بك شرّاً.
قال: كذبت، وقبل اليوم ما كنت كذّاباً. هل تذكر وأنا أماشيك في بني لوذان وأنت تقول: إنّ عثمان بن عفان كان على نفسه مسرفاً، وإنّ معاوية بن أبي سفيان ضالاً مضلاً، وإنّ إمام الهدى والحق علي بن أبي طالب؟
فقال له برير: أشهد أنّ هذا رأيي وقولي.
فقال له يزيد بن معقل: فإنّي أشهد أنّك من الضالين.
فقال له برير بن خضير: هل لك؟ فلأباهلك، ولندع الله أن يلعن الكاذب، وأن يقتل المبطل، ثمّ اخرج فلأبارزك؟
قال: فخرج، فرفعا أيديهما إلى الله يدعوانه أن يلعن الكاذب، وأن يقتل المحق المبطل، ثمّ برز كلّ واحد منهما لصاحبه، فاختلفا ضربتين، فضرب يزيد بن معقل برير بن خضير ضربة خفيفة لم تضرّه شيئاً، وضربه برير بن خضير ضربة قدّت المغفر وبلغت الدماغ؛ فخرّ كأنّما هوى من حالق وإنّ سيف برير بن خضير لثابت في رأسه. فكأنّي أنظر إليه ينضنضه من رأسه.... تاريخ الطبري ٤/٣٢٨ - ٣٢٩ في أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة.
وفي حديث هانئ بن عروة أنّ نافع بن هلال كان يقاتل يومئذ وهو يقول: أنّا الجملي، أنّا على دين علي.
قال: فخرج إليه رجل يُقال له: مزاحم بن حريث، فقال: أنّا على دين عثمان.
فقال له: أنت على دين شيطان. ثمّ حمل عليه فقتله. تاريخ الطبري ٤/٣٣١ في أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، واللفظ له، مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٥، وقد ذكر ابن كثير كلام نافع من غير أن يذكر تتمة الرواية، راجع البداية والنهاية ٨/١٩٩ في أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة.
ومن الظاهر أنّ ذلك بمرأى ومسمع من الإمام الحسين (صلوات الله عليه)، وما كانا ليخالفانه في الرأي، فكيف يصدق عليه (عليه السّلام) مع ذلك أن يلتزم بسيرة الخلفاء وفيهم عثمان؟!... إلى غير ذلك ممّا يشهد بافتعال هذه الزيادة على سيّد الشهداء (صلوات الله عليه).
وثانياً : يقول في كتابه إلى رؤساء الأخماس بالبصرة: «أمّا بعد، فإنّ الله اصطفى محمداً صلى الله عليه وآله وسلم على خلقه، وأكرمه بنبوّته، واختاره لرسالته، ثمّ قبضه الله إليه وقد نصح لعباده، وبلغ ما أرسل به صلى الله عليه وآله وسلم، وكنّا أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته وأحقّ الناس بمقامه في الناس، فاستأثر علينا قومنا بذلك فرضينا وكرهنا الفرقة وأحببنا العافية، ونحن نعلم أنّا أحقّ بذلك الحقّ المستحق علينا ممّنْ تولاه...»(١) .
وقد أكّدت ذلك العقيلة زينب الكبرى (عليها السّلام) في خطبتها الجليلة في مجلس يزيد التي هي في الحقيقة من جملة أحداث نهضة الإمام الحسين (صلوات الله عليه) وواجهاتها المضيئة.
حيث قالت (عليها السّلام) منكرة على يزيد:
فشمخت بأنفك، ونظرت في عطفك جذلان مسروراً؛ حين رأيت الدنيا لك مستوسقة، والأمور متّسقة، وحين صفا لك ملكنا وسلطاننا، فمهلاً مهلاً...(٢) . فإنّ كلامها هذا صريح في أنّ الخلافة حقّ لأهل البيت (عليهم السّلام)، وأنّ السلطان الإسلامي لهم.
وثالثاً : قد استجاب لشيعته في الكوفة، ومن المعلوم من مذهبهم أنّ الخلافة حقّ لأهل البيت (صلوات الله عليهم)... إلى غير ذلك ممّا يجده الناظر في تاريخ نهضته الشريفة من الشواهد الدالة على أنّها تبتني على استحقاق أهل البيت (عليهم السّلام) لهذا المنصب الرفيع.
____________________
١ - تاريخ الطبري ٤/٢٦٦ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين (عليه السّلام) للمصير إلى ما قبلهم، وأمر مسلم بن عقيل (رضي الله عنه)، واللفظ له، البداية والنهاية ٨/١٧٠ قصّة الحسين بن علي وسبب خروجه من مكة في طلب الإمارة وكيفية مقتله.
٢ - راجع ملحق رقم (٤).
وهو (عليه أفضل الصلاة والسّلام) بذلك وإن كان قد يخسر تأييد مَنْ يوالي الأوّلين، ويخفّف أو يفقد تعاطفهم معه، إلّا إنّه (صلوات الله عليه) كان يرى أنّ التأكيد على مبادئ أهل البيت ومذهبهم في السلطة، وتبنّيها في نهضته أهم من تكثير المؤيّدين له والمتعاطفين معه.
ولاسيما أنّ هدفه (عليه السّلام) ليس هو الانتصار العسكري كما سبق، بل الإنكار على الظالمين، وسلب الشرعية عنهم، والتضحية من أجل مصلحة الدين، والتذكير بمبادئه؛ حيث يقتضي ذلك منه (عليه السّلام) إيضاح تلك المبادئ والتركيز عليها وعلى حَفَظتها ورُعاتها؛ خدمة لها.
فوز التشيّع بشرف التضحية في أعظم ملحمة دينية
وبذلك كسب التشيّع شرف التضحية في أعظم ملحمة دينية وحركة إصلاحية في الإسلام، بل في جميع الأديان السماوية كما يظهر من النصوص، ويشهد به التأمّل والاعتبار؛ حيث كان لها أعظم الأثر في بقاء معالم الإسلام ووضوح حجّته، وهو خاتم الأديان وأشرفها.
وقد تضمّخ بتلك الدماء الزكية، وصار رمزاً للشهادة والفناء في سبيل الله (عزّ وجلّ)، وفي سبيل دينه القويم وتعاليمه السامية، وعنواناً للإنكار على الظالمين، والصرخة في وجوههم بنحو يوجب المزيد من الشدّ العاطفي نحوه، والتجاوب معه؛ ولذلك أعظم الأثر في قوّة التشيّع.
بل هي نقطة تحوّل فيه؛ حيث صار له بسببها من المخزون العاطفي ما يمدّه بالقوّة على مرّ الزمن، وشدّة المحن.
فهو يزيد الشيعة إيماناً بقضيتهم، وإصراراً على مواقفهم وثباتاً عليه، ويهوّن عليهم الاضطهاد والفجائع التي تنزل بهم مهما عظمت؛ إذ لا
فاجعة أشدّ من فاجعة الطفّ بأبعادها التي سبق التعرّض لها، كما قال الشاعر:
أنست رزيتُكم رزايانا التي |
سلفت، وهوّنتِ الرزايا الآتيه |
|
وفجايعُ الأيامِ تبقى مدة |
وتزولُ، وهي إلى القيامةِ باقيه |
بل جعل الشيعة (رفع الله تعالى شأنهم) يشعرون بالفخر والاعتزاز بما يقع عليهم بسبب تشيّعهم من المصائب والمتاعب، ويرونها أوسمة شرف لهم على مرّ العصور وتعاقب الدهور، فتشدّ عزائمهم، وترفع من معنوياتهم، وتمدّهم بالحيوية والطاقة.
كما تزيدهم ارتباطاً بالله (عزّ وجلّ) وبرسوله الكريم وأهل بيته الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين)، وتذكّرهم بدينهم القويم وتعاليمه السامية، وتحملهم على الرجوع إليها والتمسّك بها.
نقمة الظالمين على الشيعة في إحياء فاجعة الطفّ
ولذا انصبّت نقمة الظالمين - على مرّ التاريخ وحتى عصرنا الحاضر - على الشيعة وممارساتهم، ولاسيما إحياء فاجعة الطفّ؛ سواء بإقامة مجالس العزاء، أم برثاء الإمام الحسين (صلوات الله عليه)، أم بزيارة قبره وتشييده... إلى غير ذلك من وجوه الإحياء.
حيث يجدون في ذلك إنكاراً من الشيعة عليهم، وصرخة في وجوههم، وتعرية لهم، وتحريضاً عليهم بنحو قد يفقدهم رشدهم في معالجة المواقف، والتعامل معها؛ فيكون ردّ الفعل منهم عليها عنيفاً بنحو يؤكّد ظلامة الشيعة والتشيّع، ويعود في صالحهما على الأمد البعيد.
فاجعة الطفّ زعزعت شرعية نظام الخلافة عند الجمهور
الجهة الثانية: إنّ فاجعة الطفّ بأبعادها السابقة كما هزّت ضمير المسلمين زعزعت شرعية نظام الخلافة عند الجمهور، بما في ذلك خلافة الأوّلين؛ حيث لا يتعقّل المنصف شرعية نظام ينتهي بالإسلام والمسلمين في هذه المدّة القصيرة إلى هذه المأساة الفظيعة والجريمة النكراء، وتداعياتها السريعة.
ولاسيما أنّ هذه الفاجعة - مع فضاعتها في نفسها - قد نبّهت إلى ظلامة أهل البيت (صلوات الله عليهم) على طول الخطّ، وإلى جميع سلبيات النظام المذكور، ومآسيه المتتابعة في تاريخ الإسلام والمسلمين، وإلى حجم الخسارة التي تعرّض لها الإسلام نتيجة انحراف السلطة فيه عن أهل البيت الذين أذهب الله تعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً.
فاجعة الطفّ هي العقبة الكؤود أمام نظام الخلافة
وقد أكّد على ذلك أئمّة أهل البيت (صلوات الله عليهم) في أحاديثهم الكثيرة، وفي الزيارات الواردة عنهم للإمام الحسين (صلوات الله عليه).
وإذا كان احترام الجمهور للصدر الأوّل، بل تقديسهم له؛ نتيجة العوامل المتقدّمة - ومنها جهود معاوية الحثيثة - قد كان هو العقبة الكؤود أمام دعوى النصّ التي يتبّناها الشيعة كما سبق، فإنّ فاجعة الطفّ صارت هي العقبة الكؤود أمام شرعية نظام الخلافة عند الجمهور، واحترام الصدر الأوّل ممّنْ جرى على ذلك النظام وتقديسهم.
بل قد آذنت بنسف ذلك كلّه بعد أن كان من الناحية الواقعية هشّاً غير محكم الأساس، ولا قوي البرهان.
موقف بعض علماء الجمهور من إحياء الفاجعة
وقد أدرك ذلك كثير من علماء الجمهور حتى قبل ظهور دعوة التكفيريين، الذين جعلوا من الدين حرمة إحياء الذكريات المجيدة في الإسلام، والقيام بمظاهر التمجيد والتقديس لرموزه العظام.
فإنّ الجمهور - مع استهجانهم لفاجعة الطفّ عند الحديث عنها، وتعظيمهم لمقام الإمام الحسين (عليه السّلام) لا يحاولون إحياء ذكرى فاجعة الطفّ بما يتناسب مع مبانيهم، بل لا يطيق كثير منهم النيل من الظالمين والتذكير بجرائمهم.
وقد حاول كثير منهم المنع من إحياء تلك الذكرى الأليمة، والتذكير بظلامة أهل البيت (صلوات الله عليهم) وما جرى عليهم، والضغط في الاتجاه المذكور بمختلف الوسائل والحجج.
بل منعوا من لعن القائمين بتلك الجريمة النكراء والنيل منهم، وإن كان في جرائمهم ما لا يخصّ الشيعة، كواقعة الحرّة الفظيعة، وهتك حرمة الحرم، وضرب مكة المكرّمة والكعبة المعظّمة بالمنجنيق وغير ذلك.
وقد حاولوا تجاهل ذلك كلّه أو التخفيف منه؛ من أجل حمل المسلمين على نسيان فاجعة الطفّ، وعدم التركيز عليها والاهتمام بها؛ لما للتذكير بها من الآثار السلبية على مبانيهم في نظام الحكم التي تسالموا عليه من دون أن يستندوا إلى ركن وثيق يقف أمام الهزّة العاطفية التي تحدثها هذه الذكرى الأليمة، والحساب المنطقي الذي تنبّه له.
كلام الغزالي
بل انتهى الأمر ببعضهم إلى تحريم التعرّض لهذه الفاجعة وما يتعلّق بها. فعن الغزالي: يحرم على الواعظ وغيره رواية مقتل الحسين (رضي الله عنه) وحكاية ما جرى
بين الصحابة من التشاجر والتخاصم؛ فإنّه يهيج بغض الصحابة، والطعن فيهم، وهم أعلام الدين، وما وقع بينهم من المنازعات فيُحمل على محامل صحيحة. فلعلّ ذلك لخطأ في الاجتهاد، لا لطلب الرئاسة أو الدنيا كما لا يخفى(١) .
كلام التفتازاني
وقال سعد الدين التفتازاني: ما وقع بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات - على الوجه المسطور في كتب التواريخ وعلى السُنّة الثقات - يدلّ بظاهره على أنّ بعضهم قد حاد عن طريق الحقّ، وبلغ حدّ الظلم والفسق، وكان الباعث له الحقد والعناد والحسد واللداد، وطلب الملك والرياسة، والميل إلى اللذات والشهوات؛ إذ ليس كلّ صحابي معصوم، ولا كلّ مَنْ لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخير موسوم.
إلاّ إنّ العلماء لحسن ظنّهم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا لها محامل وتأويلات بها تليق، وذهبوا إلى أنّهم محفوظون عمّا يوجب التضليل والتفسيق؛ صوناً لعقائد المسلمين عن الزيغ والضلالة في حق كبار الصحابة، سيّما المهاجرين والأنصار المبشرين بالثواب في دار القرار.
وأمّا ما جرى بعدهم من الظلم على أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن الظهور بحيث لا مجال للإخفاء، ومن الشناعة بحيث لا اشتباه على الآراء؛ إذ تكاد تشهد به الجماد والعجماء، ويبكي له مَنْ في الأرض والسماء، وتنهدّ منه الجبال، وتنشقّ الصخور، ويبقى سوء عمله على كرّ الشهور ومرّ الدهور، فلعنة الله على مَنْ باشر، أو رضي أو سعى، ولعذاب الآخرة أشدّ وأبقى.
____________________
١ - روح البيان - للبروسوي ٨/٢٤ في تفسير آية:٢٥ سورة ص، وهي قوله تعالى:( فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ ) ، الغرر البهية ٥/٧١ باب البغاة.
فإنّ قيل: فمن علماء المذهب مَنْ لم يجوّز اللعن على يزيد مع علمهم بأنّه يستحقّ ما يربو على ذلك ويزيد.
قلنا: تحامياً عن أن يرتقي إلى الأعلى فالأعلى كما هو شعار الروافض على ما يُروى في أدعيتهم، ويجري في أنديتهم.
فرأى المعتنون بأمر الدين إلجام العوام بالكلية؛ طريقاً إلى الاقتصاد في الاعتقاد وبحيث لا تزلّ الأقدام على السواء، ولا تضلّ الأفهام بالأهواء، وإلاّ فمَنْ يخفى عليه الجواز والاستحقاق؟! وكيف لا يقع عليه الاتفاق؟!(١) .
كلام الربيع بن نافع الحلبي حول معاوية
وهما بذلك يجريان على سنن أبي توبة الربيع بن نافع الحلبي حيث يقول: معاوية سترٌ لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه(٢) .
وقد أقرّه على ذلك غير واحد، لكنّهم غفلوا أو تغافلوا عن أنّ مبانيهم ومباني أهل مذهبهم في احترام هؤلاء وتقديسهم، وشرعية خلافتهم لو كانت محكمة الأساس قوّية البرهان، ولم تكن هشّة تنهار بالبحث والتحقيق لما خافوا عليها من طريقة الشيعة وشعارهم، ولما اضطروا من أجل الحفاظ عليها إلى إلجام العوام بالكلية، وإلى تحريم لعن الظالمين وكشف فضائحهم مع وضوح استحقاقهم لهما، ولما يزيد عليهما( قُلْ فَللّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ) (٣) .
____________________
١ - شرح المقاصد في علم الكلام ٢/٣٠٦ - ٣٠٧.
٢ - البداية والنهاية ٨/١٤٨ أحداث سنة ستين من الهجرة، ترجمة معاوية، واللفظ له، تاريخ دمشق ٥٩/٢٠٩ في ترجمة معاوية بن صخر أبي سفيان.
٣ - سورة الأنعام/١٤٩.
موقف الغلاة لم يمنع الشيعة من ذكر كرامات أهل البيت (عليهم السّلام)
ولذا نرى الشيعة قد امتحنوا بالغلاة الذين يرتفعون بأئمّة أهل البيت (صلوات الله عليهم) عن مراتبهم التي رتّبهم الله تعالى فيها إلى كونهم أنبياء أو آلهة.
وقد استغل ذلك أعداء الشيعة فجعلوا الغلو والغلاة وسيلة للتشنيع على الشيعة والتشيّع والتشهير بهم من دون إنصاف ولا رحمة.
لكنّ الشيعة - مع شدّة موقفهم من الغلاة، ومباينتهم لهم، وتصريحهم بكفرهم - لم يمنعهم ذلك من التركيز على رفعة مقام أهل البيت (صلوات الله عليهم) وبيان كراماتهم ومعاجزهم، ولم يحذروا أن يجرّهم ذلك للغلو، أو يكون سبباً للتشنيع عليهم.
وذلك لأنّهم على ثقة تامّة من قوّة عقيدتهم بحدودها المباينة للغلو، وقوّة أدلتها بحيث لا يخشون من أن ينجرّوا من ذلك للغلو، أو يلتبس الأمر على جمهورهم بنحو يفقدهم السيطرة عليه.
ولو فرض أن حصل لبعض الناس نحو من الإيهام والالتباس سهل على علماء الشيعة السيطرة على ذلك، وكشف الالتباس، ودفع الشبهة.
كما لا يهمهم تشنيع أعدائهم عليهم بذلك بعد ثقتهم بسلامة عقيدتهم وقوّة أدلتها، وشعورهم بأنّ التهريج والتشنيع أضعف من أن يوهن ذلك، بل هو نتيجة شعور الطرف المقابل بضعفه في مقام الاستدلال والحساب المنطقي.
محاولة كثير من الجمهور الدفاع للظالمين
بل إنّ كثيراً من الجمهور - من حيث يشعرون أو لا يشعرون - قد جرّتهم عقدة الحذر من قوّة التشيّع - نتيجة الظلامات التي وقعت عليه، خصوصاً فاجعة الطفّ - إلى الدفاع عن جماعة من الظالمين لأهل البيت (عليهم السّلام) ولشيعتهم،
قد أمعنوا في الجريمة، وضجّت الدنيا بفضائحهم بحيث سقطوا عن الاعتبار، وصاروا في مزابل التاريخ، كيزيد بن معاوية وأمثاله حتى قد يبلغ الأمر ببعضهم إلى تبنّي هؤلاء واحترامهم وتبجيلهم.
الدفاع عن الظالمين يصبّ في صالح التشيّع
وهم لا يدركون - بسبب هذه العقدة - أنّ هذا الدفاع والتبنّي لا ينفعان هؤلاء المجرمين، ولا يرفعان من شأنهم، ولا يضرّان الشيعة، بل يترتب عليهما أمران لهما أهميتهما في صالح الشيعة والتشيّع:
الأوّل: إنّ المدافعين والمتبنين لهؤلاء قد أسقطوا اعتبار أنفسهم؛ لأنّ هؤلاء الظلمة قد بلغوا من السقوط والجريمة بحيث يبرأ منهم مَنْ يحترم نفسه، ويشعر بكرامتها عليه.
كما إنّ مَنْ يدافع عنهم أو يتبنّاهم يتلوّث بجرائمهم، ويهوي للحضيض معهم. فهو كمَنْ يحاول أن ينتشل شخصاً من مستنقع فيهوي في ذلك المستنقع معه.
الثاني: إنّ ذلك يكشف عن نصب هؤلاء النفر - من المتبنين والمدافعين - لأهل البيت (صلوات الله عليهم)، وإنّه لا داعي لهم للدفاع والتبنّي لهذه النماذج المتميزة في الجريمة، والتي صارت في مزابل التاريخ إلّا بغض أهل البيت (عليهم السّلام).
وكفى الشيعة فخراً أن يهوي خصومهم للحضيض، وأن تنكشف حقيقتهم، وأنّهم في الواقع خصوم لأهل البيت (صلوات الله عليهم) ونواصب لهم، كما يكفي ذلك محفّزاً للشيعة على التمسّك بحقهم والاعتزاز به، وفي قوّة بصيرتهم في أمرهم، وإصرارهم على حقّهم.
فهؤلاء بموقفهم من الشيعة نظير المشركين في موقفهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم
حيث سلاه الله (عزّ وجلّ) بقوله:( قَدْ نَعْلَمُ أنّه لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فإنّهم لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ ) (١) .
مضافاً إلى أن ذلك يستبطن الاعتراف عملياً بارتباط خط الخلافة عند الجمهور بعضه ببعض، بحيث يتحمل السابق تبعة اللاحق، ولا يسهل فصل بعضه عن بعض، كما يؤكد الشيعة على ذلك، تبعاً لأئمتهم (صلوات الله عليهم). والحمد لله رب العالمين.
____________________
١ - سورة الأنعام/٣٣.
المقام الثالث
في الإعلام والإعلان عن دعوة التشيّع ونشر ثقافته
إنّ فظاعة فاجعة الطفّ حقّقت الأرضية الصالحة لاستثمارها لصالح مذهب التشيّع، وذلك برثاء سيّد الشهداء (عليه الصلاة والسّلام) والتفجّع له، وزيارته والتأكيد على ظلامته.
وانطلق الشيعة من ذلك لبيان ظلامة أهل البيت (صلوات الله عليهم)، والتأكيد على رفعة مقامهم، وعظيم شأنهم، وعلى جور ظالميهم وخبثهم وسوء منقلبهم، ثمّ الاهتمام بإحياء المناسبات المتعلّقة بأهل البيت جميعاً.
اهتمام الشيعة بإحياء الفاجعة وجميع مناسبات أهل البيت (عليهم السّلام)
وإذا كان أثر فاجعة الطفّ قد خفّ في نفوس عموم المسلمين بمرور الزمن، أو أدرك المخالفون لخطّ أهل البيت ضرورة تناسيها وتجاهلها؛ نتيجة لما سبق، فإنّ الشيعة - وبدفع من أئمّتهم (صلوات الله عليهم) - قد حاولوا التشبّث بها والتركيز عليها، واستثمارها بالنحو المتقدّم، ولم تمضِ مدّة طويلة حتى صار ذلك من سمات الشيعة المميّزة لهم والتي يقوم عليها كيانهم.
ويشدّ من عزائمهم ما ورد عن أئمّتهم (صلوات الله عليهم) من عظيم أجر ذلك وجزيل ثوابه، وما يلمسونه - على طول الخطّ - من المدّ الإلهي والكرامات المتعاقبة التي تزيدهم بصيرة في أمرهم، وتمنحهم قوّة وطاقة على
المضي فيه، وتحمّل المتاعب والمصاعب في سبيله.
منع الظالمين من إحياء مناسبات أهل البيت (عليهم السّلام)
وقد أثار ذلك حفيظة الظالمين؛ فجدّوا في منعهم والتنكيل بهم، وحفيظة كثير من المخالفين فجدّوا في الإنكار والتشنيع عليهم بمختلف الأساليب.
وذلك وإن كان قد يعيقهم عن بعض ما يريدون في الفترات المتعاقبة، إلّا إنّه يتجلّى لهم به ظلامة أهل البيت (صلوات الله عليهم) على طول الخطّ، وظلامة شيعتهم تبعاً لهم.
حتى قال الشاعر تعريضاً بمواقف المتوكّل العباسي حينما هدم قبر الإمام الحسين (صلوات الله عليه)، ومنع الناس من زيارته، واشتدّ في ذلك:
تاللهِ إن كانت أمية قد أتت |
قتلَ ابنَ بنتِ نبيّها مظلوما |
|
فلقد أتاهُ بنو أبيهِ بمثله |
هذا لعمركَ قبرهُ مهدوما |
|
أسفوا على أن لا يكونوا شاركوا |
في قتلهِ فتتبّعوهُ رميما(١) |
وقد جرى الخلف على سنن السلف وإن اختلفت الأساليب والصور، والمبرّرات والحجج.
أثر المنع المذكور على موقف الشيعة
وبذلك يتأكّد ولاء الشيعة لأهل البيت (صلوات الله عليهم)، وإصرارهم على إحياء أمرهم، وصاروا يستسهلون المصاعب، ويتحمّلون المصائب في سبيل ذلك؛ تعاطفاً معهم (عليهم السّلام)، وأداءً لعظيم حقّهم عليهم.
____________________
١ - وفيات الأعيان ٣/٣٦٥ في ترجمة البسامي الشاعر، واللفظ له، تاريخ الإسلام ١٧/١٩ أحداث سنة خمس وثلاثين ومئتين من الهجرة، هدم قبر الحسين، البداية والنهاية ١١/١٤٣ أحداث سنة أربع وثلاثمئة، وغيرها من المصادر.
كما يتجلّى لهم أهمية هذه الممارسات والشعائر في تثبيت وجودهم، وتأكيد هويتهم، وإغاظة عدوهم، فيزيدهم ذلك تمسّكاً به، وإصراراً عليه؛ كردّ فعل لمواقف أعدائهم معهم، وظلامتهم لهم.
وبمرور الزمن وتعاقب المحن، واستمرار الصراع وتفاقمه صارت هذه الشعائر جزءاً من كيان الشيعة وتجذّرت في أعماقهم، وأخذت شجرتها تنمو وتورق وتخفق بظلالها عليهم.
وكان لها أعظم الأثر لصالح دعوتهم في أمور:
أثر إحياء المناسبات المذكورة في حيوية الشيعة ونشاطهم
الأوّل : حيويتهم ونشاطهم؛ لأنّ فعالياتهم وممارساتهم في إحيائها نشيطة جدّاً، وملفتة للنظر كما هو ظاهر للعيان.
مضافاً إلى ما أشرنا إليه آنفاً من أنّها فتحت الباب لإحياء جميع مناسبات أهل البيت (صلوات الله عليهم)، وهي كثيرة جدّاً على مدار السُنّة وذلك يجعل جمهور الشيعة في عطاء مستمر، وحركة دائمة، والحركة دليل الحياة كما قيل.
أثر هذا الإحياء في جمع شمل الشيعة وتقوية روابطهم
الثاني : جمع شملهم وتماسكهم، وتثبيت وحدتهم، وتقوية روابطهم حيث يذكّرهم ذلك بمشتركاتهم الجامعة بينهم؛ من موالاة أهل البيت (صلوات الله عليهم)، وموالاة أوليائهم، ومعاداة أعدائهم، وما يتفرّع على ذلك من أحزان وأفراح يقومون بإحيائها بتعاون ودعم مشترك.
وإنّ الأموال التي تُنفق في سبيل ذلك من الكثرة بحدّ يلفت النظر؛ سواءً كانت مشاريع ثابتة - كالحسينيات والأوقاف ونحوها - أم نفقات مصروفة
لسدّ الحاجيات المتجدّدة، كالإطعام والاستضافة وسائر الخدمات، ومكافآت الخطباء والذاكرين وغيره.
ويقوم بذلك جمهور الشيعة وخاصّتهم حسبما يتيسّر لكلّ أحد ويقتنع به بكامل الاختيار، بل الرغبة، وقد يصل الأمر إلى الإصرار؛ نتيجة الالتزام الشرعي - بسبب النذر -، أو وفاءً بالوعد والالتزام النفسي، أو جرياً على العادة المستحكمة... إلى غير ذلك.
ومن الطبيعي أن يكون ذلك كلّه سبباً في إثارة العواطف وتبادلها بين أفرادهم وجماعاتهم، وتخفيف حدّة الخلاف بينهم؛ بسبب وحدة المصيبة والسعي والهدف، والشعور بشرف الروابط وسموّها.
أثر الإحياء المذكور في تثبيت هوية الشيعة
الثالث : تثبيت هويتهم في تولّي أهل البيت (صلوات الله عليهم) ومَنْ والاهم، والبراءة من أعدائهم وظالميهم وأتباعهم كما تطفح بذلك الزيارات الواردة عن الأئمّة (صلوات الله عليهم) التي يتلونها، وتعجّ به مجالس العزاء والأفراح التي يقيمونها بمختلف صورها، وأشعار المدح والرثاء التي يكثرون من إنشائها وإنشادها. وقد أشار إلى ذلك سعد الدين التفتازاني في كلامه المتقدّم في المقام الثاني(١) .
نشر الثقافة العامّة والدينية بسبب الإحياء المذكور
الرابع : تثقيف جمهورهم بالثقافة العامّة، والثقافة الدينية والمذهبية الخاصّة وتعميقها فيهم، فإنّ إحياء تلك المناسبات وإن كان الهدف منه بالدرجة الأولى
____________________
(١) تقدم في ص: ٤٢٠.
هو عرض الجانب العاطفي الذي يخصّ المناسبة التي يراد إحياؤها وما يناسب ذلك، إلّا إنّه كثيراً ما تكون منبراً للثقافة العامّة، والثقافة الدينية والمذهبية خاصة.
وبذلك أمكن نشر الثقافة الدينية والشيعية نسبياً بين جمهور الشيعة بعد أن كان التثقيف العام في غالب الدول والمناطق التي يتواجد فيها الشيعة غير شيعي، بل هو على الطرف النقيض للثقافة الشيعية.
وربما كان جمهور الشيعة وعوامهم أثقف نسبياً من جمهور وعوام غيرهم ببركة تلك المناسبات الشريفة، ولما سبق من اهتمام علماء الجمهور بإبعاد جمهورهم عن تراثهم، لما فيه من الثغرات المنبهة لحق التشيّع.
تأثير إحياء تلك المناسبات في إصلاح الشيعة نسبياً
كما قد تكون المناسبات المذكورة سبباً في تأثر جمهور الشيعة نسبياً بأخلاق أهل البيت (صلوات الله عليهم) الرفيعة؛ في الصدق والأمانة، وسجاحة الخلق ولين الجانب، وغير ذلك من الصفات الحميدة.
فإنّ الشيعة - كأفراد - وإن لم يخلوا عن سلبيات كثيرة في هذا الجانب، إلّا إنّه بمقارنتهم مع غيرهم قد يبدو الفرق واضحاً؛ نتيجة نشر ثقافة أهل البيت (صلوات الله عليهم) عند إحياء المناسبات المذكورة حيث تترك آثارها في أنفسهم وبصماتها في سلوكهم، ويتفاعلون بها نسبياً.
وقد أشار إلى بعض جوانب ذلك ابن أبي الحديد حيث قال في ترجمته لأمير المؤمنين (صلوات الله عليه): وأمّا سجاحة الأخلاق، وبشر الوجه، وطلاقة المحيّى والتبسّم فهو المضروب به المثل فيه حتى عابه بذلك أعداؤه. قال عمرو بن العاص لأهل الشام: إنّه ذو دعابة شديدة....
وعمرو بن العاص إنّما أخذها عن عمر بن الخطاب؛ لقوله لما عزم على
استخلافه: لله أبوك، لولا دعابة فيك. إلّا إنّ عمر اقتصر عليه، وعمرو زاد فيها وسمجه.
قال صعصعة بن صوحان وغيره من شيعته وأصحابه: كان فينا كأحدنا، لين جانب، وشدّة تواضع، وسهولة قياد. وكنّا نهابه مهابة الأسير المربوط للسياف الواقف على رأسه....
وقد بقي هذا الخلق متوارثاً متناقلاً في محبيه وأوليائه إلى الآن، كما بقي الجفاء والخشونة والوعورة في الجانب الآخر. ومَنْ له أدنى معرفة بأخلاق الناس وعوائدهم يعرف ذلك(١) .
إيصال مفاهيم التشيّع بإحياء تلك المناسبات
الخامس: رفع رايتهم وإسماع دعوتهم لغيرهم؛ لأنّ تميّزهم بإحياء تلك المناسبات، ومواظبتهم على رفع شعائر الحبّ والولاء فيه، وتأكيدهم على ظلامة أهل البيت (صلوات الله عليهم)، واستثارتهم للعواطف بمناسبة ذلك يلفت أنظار الآخرين إليهم، ويحملهم على الاحتكاك بهم، والتعرّف على ما عندهم، ولاسيّما أنّ إحياء هذه المناسبات يكون غالباً بنحو مثير وملفت للنظر.
وكثيراً ما يكون ذلك سبباً لهداية الآخرين وتقبّلهم لدعوتهم ودخولهم في حوزتهم؛ لتفاعلهم بتلك المناسبات بنحو يكون محفّزاً لسماع أدلّة الشيعة والنظر في حجّتهم، ثمّ الاستجابة لهم؛ لما ذكرناه في المقام الأوّل من قوّة أدلّة الشيعة، وموافقة دعوتهم للمنطق السليم، ولاسيما أنّها قد تدعم بالمدّ الإلهي، وظهور الكرامات الباهرة التي تأخذ بالأعناق.
والظاهر أنّ انتشار التشيّع في كثير من بقاع المعمورة، وظهور دعوته
____________________
١ - شرح نهج البلاغة ١/٢٥ - ٢٦.
وتوسّعها بمرور الزمن إنّما كانت بسبب إحياء فاجعة الطفّ، وإصرار الشيعة على ذلك، والانفتاح منها على بقيّة مناسبات أهل البيت (صلوات الله عليهم) وعلى ثقافتهم؛ فإنّهم لا يملكون من القوى المادية ما ينهض بهذا العبء الثقيل، ويحقّق هذه النتائج الرائعة.
خلود دعوة التشيّع بإحياء هذه المناسبات
السادس: إنّ دعوة التشيّع (أعزها الله تعالى) وإن تعهد الله (عزّ وجلّ) ببقائها ظاهرة مسموعة الصوت؛ لتقوم بها الحجّة على الناس، إلّا إنّ الظاهر أنّ لفاجعة الطفّ أعظم الأثر في بقائها رغم الضغوط الكثيرة التي تعرّضت لها.
وذلك لأنّ تفاعل الجمهور بالفاجعة واهتمامهم بإحيائها لا يتوقّف على دفع الخاصة لهم - كرجال الدين أو غيرهم - وتشجيعهم إيّاهم؛ ليسهل على العدو القضاء عليها بتحجيم دور الخاصة، بالترغيب والترهيب، وصنوف التنكيل حتى التصفية الجسدية كما حصل ذلك قديماً وحديثاً.
بل هي قد أخذت موقعها من نفوس الجمهور على اختلاف طبقاتهم، وتجذّرت في أعماقهم بحيث يهتمون بإحيائها بأنفسهم، ويندفعون لذلك بطبعهم، وكأنّها جزء من كيانهم.
ولا تزيدهم الضغوط في اتجاه منعه، أو التخفيف منه إلّا إصراراً وتمسّكاً حيث يرون فيها تعدّياً على حقّهم الذي يؤمنون به، وتحدّياً لهم كأمّة، وتجاهلاً لشخصيتهم، وجرحاً لشعورهم وعواطفهم، ونيلاً من كرامتهم.
ولو اضطرتهم الضغوط للتوقّف عن الإعلان بممارساتهم في إحيائها فلا يؤثّر ذلك على موقعها من نفوسهم، وتفاعلهم بها، بل يزيدهم ذلك تعلّقاً
بها، وانشداداً لها، ونقمة على الظالمين مع الإصرار على إحيائها سرّاً بما يتيسّر، ويضحّون في سبيل ذلك بالغالي والنفيس.
وحيث لا يتيسّر القضاء على الجمهور لكثرتهم، تبقى الجذوة كامنة في نفوسهم، والعواطف محتدمة حتى إذا سنحت الفرصة تدفّق المخزون العاطفي فكان النشاط مضاعفاً، والفعاليات مكثفة؛ تعويضاً عمّا سبق، وتحدّياً للظالمين؛ ولذا كان مصير الضغوط عبر التاريخ الفشل الذريع والخيبة الخاسرة.
ولمّا كان إحياء هذه المناسبة الشريفة بمختلف وجوهها رمزاً للتشيّع، وسبباً في رسوخ قدمه وتماسكه وتثبيت هويته - كما سبق - كان لاستمرار جمهور الشيعة فيها، وإصرارهم عليها بالوجه المذكور أعظم الأثر في بقاء التشيّع والحفاظ عليه، بل قد يكون هو الدرع الواقي له، والقلعة الحصينة التي تعصمه.
فاجعة الطفّ نقطة تحول مهمة في صالح التشيّع
وقد ظهر من جميع ما سبق أنّ نهضة الإمام الحسين (صلوات الله عليه) التي ختمت بفاجعة الطفّ صارت نقطة تحوّل مهمة في مذهب التشيّع؛ حيث صار لها أعظم الأثر في قوّته، ورسوخ قدمه وبقائه، ووضوح حجّته وسماع دعوته، وتوسّعه بمرور الزمن رغم الضغوط الكثيرة، والصراع العنيف، ويأتي في الفصل الثالث من المقصد الثالث ما ينفع في المقام إن شاء الله تعالى.
قال عزّ من قائل:( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء * تُؤْتِي أُكُلَهَا كلّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَ... ) (١) .
وهو المناسب لحجم التضحية التي أقدم عليها الإمام الحسين (صلوات الله عليه) صابراً محتسباً، راضياً بقضاء الله تعالى وقدره، مستجيباً لأمره، واثقاً
____________________
١ - سورة إبراهيم/٢٤ - ٢٥.
بتسديده ونصره.
وبذلك يتّضح وجه قوله (صلوات الله عليه) في كتابه المتقدّم: «أمّا بعد فإنّ مَنْ لحق بي استشهد، ومَنْ لم يلحق بي لم يدرك الفتح»(١) .
فجزاه الله تعالى عن الدين وأهله أفضل جزاء المحسنين، وصلّى الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الميامين الذين استشهدوا معه، والذين سمعوا الداعي فأجابوه، ووثقوا بالقائد فاتّبعوه، ولم تأخذهم في الله لومة لائم، ولا عاقهم عن أداء واجبهم عائق مهما بلغ.
و( الْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللهُ ) (٢) ، وله الشكر أبداً دائماً سرمداً، ونسأله أن يثبّتنا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة، ويزيدنا إيماناً وتسليماً إنّه أرحم الراحمين، وولي المؤمنين، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير.
____________________
١ - تقدّمت مصادره في/٤٦.
٢ - سورة الأعراف/٤٣.
الفصل الثاني
في العبر التي تستخلص من فاجعة الطفّ
ويحسن التعرّض لها هنا من أجل أن يسترشد بها الناس عامّة، والذين يحاولون الإصلاح خاصّة.
والكلام هنا في مقامين:
المقام الأوّل
في آليّة العمل
إنّ الناظر في نهضة الإمام الحسين (صلوات الله عليه) يرى بوضوح الحفاظ في هذه النهضة المباركة على المبادئ الشريفة والمثل السامية، ووضوح الهدف، والبعد عن اللف والدوران كما يظهر من كثير ممّا تقدّم وغيره.
سلامة آليّة العمل وشرفه
١- فالإمام الحسين (صلوات الله عليه) يعلن من يومه الأوّل في وصيته لأخيه محمد بن الحنفية المتقدّمة أنّ هدفه الإصلاح في الأُمّة والسير بسيرة جدّه وأبيه (صلوات الله عليهما وآلهما)(١) ، وإن كانت هذه السيرة لا تعجب الكثيرين على ما أشرنا إليه آنفاً.
____________________
١ - تقدّم في/٤١٢.
٢- كما إنّه يعلن فيها عن أنّ موقفه ممّن يردّ عليه ذلك هو الصبر وانتظار حكم الله تعالى من دون أن يهدّد بالعنف والانتقام منه، أو يلجأ للشتم والتهريج والتشنيع(١) .
٣- ويعلن في كتابه إلى بني هاشم أنّ مصير مَنْ يتبعه الشهادة؛ ليكونوا على بصيرة من أمرهم من دون أن يلوّح لهم بأمل النجاح العسكري من أجل حثّهم على الالتحاق به ونصره(٢) .
٤- وبنحو ذلك يعلن في خطبته في مكة المكرّمة المتقدّمة عندما عزم على الخروج إلى العراق حيث أعلن (عليه السّلام) أنّه سوف يُقتل، وأنّه لا بدّ لمَنْ يتبعه أن يكون باذلاً في أهل البيت (صلوات الله عليهم) مهجته، موطّناً على لقاء الله (عزّ وجلّ) نفسه(٣) .
٥- ولما أرسل (صلوات الله عليه) مسلم بن عقيل (عليه السّلام) إلى الكوفة لم يمنه النصر، بل قال له: «إنّي موجّهك إلى أهل الكوفة، وسيقضي الله في أمرك ما يحبّ ويرضى، وأنا أرجو أن أكون أنا وأنت في درجة الشهداء...»(٤) .
٦- وحينما بلغه (عليه السّلام) في الطريق مقتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة وعبد الله بن يقطر، وخذلان أهل الكوفة له، خطب مَنْ معه وأعلمهم بذلك، وأذن لهم بالانصراف.
فانصرف عنه كثير ممّن تبعه في الطريق؛ لظنّهم أنّه يأتي بلداً أطاعه أهله،
____________________
١ - تقدّم في/٤١٢.
٢ - تقدّم في/٤٦.
٣ - تقدّم في/٢٧.
٤ - مقتل الحسين - للخوارزمي ١/١٩٦ في مقتل مسلم بن عقيل، واللفظ له، الفتوح - لابن أعثم ٥/٣٦ ذكر كتاب الحسين بن علي إلى أهل الكوفة.
فكره (صلوات الله عليه) أن يسيروا معه إلّا على علم بما يقدمون عليه(١) .
٧- ولما طلبوا من سفيره مسلم بن عقيل أن يغتال ابن زياد حينما جاء لزيارة شريك في دار هاني بن عروة لم يفعل ما أرادوا منه، ولما سُئل عن ذلك كان في جملة عذره حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه: «إنّ الإيمان قيد الفتك»(٢) .
٨- وفي شراف أمر الإمام الحسين (صلوات الله عليه) فتيانه أن يستكثروا من الماء، وسقى به جيش الحرّ بن يزيد الرياحي تفضّلاً منه عليهم؛ لتحلّيه بمكارم الأخلاق مع أنّهم في صف أعدائه، وقد جاؤوا ليأخذوه ومَنْ معه أسرى إلى ابن زياد؛ ليمضي حكمه فيهم(٣) .
٩- ولما منعه الحرّ من النزول في نينوى أو الغاضرية أو شفية قال زهير بن القين (رضوان الله تعالى عليه) للإمام الحسين (عليه السّلام): إنّه لا يكون والله بعد ما ترون إلّا ما هو أشدّ منه يابن رسول الله، وإنّ قتال هؤلاء الساعة أهون علينا من قتال مَنْ يأتينا من بعدهم؛ فلعمري، ليأتينا من بعد مَنْ ترى ما لا قِبَل لنا به. فقال له الإمام الحسين (صلوات الله عليه): «ما كنت لأبدأهم بالقتال»(٤) .
وذلك منه (عليه السّلام) غاية في التنزّه عن البغي والعدوان، أو عن أن يتّهم بشيء
____________________
١ - مقتل الحسين - للخوارزمي ١/٢٢٩ واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/٤٣ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر مسير الحسين إلى الكوفة، تاريخ الطبري ٤/٣٠١ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، الفصول المهمة ٢/٨٠٦ - ٨٠٧ الفصل الثالث، فصل في ذكر مخرجه (عليه السّلام)، وقريب منه في البداية والنهاية ٨/١٨٢ أحداث سنة ستين من الهجرة، صفة مخرج الحسين إلى العراق، وغيرها من المصادر.
٢ - مقاتل الطالبيين/٦٥ مقتل الحسين بن علي (عليه السّلام)، تاريخ الطبري ٤/٢٧١ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين (عليه السّلام)، الكامل في التاريخ ٤/٢٧ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين (عليه السّلام).
٣ - تقدّمت مصادره في/٣١.
٤ - تقدّمت مصادره في/٣٤.
من ذلك تحريفاً للواقع، وتشويهاً للحقيقة، وتهريجاً عليه.
١٠- ومثله ما ورد من أنّ أصحاب الإمام الحسين (عليه السّلام) لما أشعلوا النار في الحطب في الخندق الذي حفروه حولهم عندما حوصروا، نادى الشمر: يا حسين، استعجلت النار في الدنيا قبل يوم القيامة.
فقال مسلم بن عوسجة (رضوان الله عليه) للإمام الحسين (عليه السّلام): يابن رسول الله جعلت فداك، ألا أرميه بسهم؟ فإنّه قد أمكنني، وليس يسقط سهم. فالفاسق من أعظم الجبّارين.
فقال له الإمام الحسين (صلوات الله عليه): «لا ترمه؛ فإنّي أكره أن أبدأهم»(١) .
١١- ولما حوصر (عليه السّلام) وهُدّد بالمناجزة والقتال، خطب أصحابه ليلة العاشر من المحرّم وقال في جملة ما قال: «أمّا بعد، فإنّي لا أعلم أصحاباً أوفى ولا أخير من أصحابي، ولا أهل بيت أبرّ ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عنّي خيراً. ألا وإنّي لأظنّ يومنا من هؤلاء الأعداء غداً، وإنّي قد أذنت لكم جميعاً فانطلقوا في حِلّ ليس عليكم منّي ذمام. هذا الليل قد غشيكم فاتّخذوه جملاً، وليأخذ كلّ رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي. فجزاكم الله جميعاً خيراً. ثمّ تفرّقوا في البلاد في سوادكم ومدائنكم حتى يفرّج الله؛ فإنّ القوم يطلبونني، ولو أصابوني لهوا عن طلب غيري»(٢) .
كلّ ذلك من أجل أن يكون موقف أصحابه معه عن قناعة تامّة غير مشوبة بإحراج أو حياء أو نحو ذلك ممّا قد يستغلّه المصلحيون، خصوصاً في مثل هذه الظروف الحرجة؛ حيث قد يسلكون فيها الطرق الملتوية ويتشبّثون بالذرائع الواهية في محاولة تكثير الأعوان، وضمان نصرتهم له.
____________________
١ - تاريخ الطبري ٤/٣٢٢ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة.
٢ - الكامل في التاريخ ٤/٥٧ - ٥٨ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، واللفظ له، تاريخ الطبري ٤/٣١٧ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة.
١٢- ومثل ذلك ما عن الأسود بن قيس العبدي قال: قيل لمحمد بن بشير الحضرمي: قد أُسر ابنك بثغر الرّي. قال: عند الله أحتسبه ونفسي. ما كنت أحبّ أن يؤسر، ولا أن أبقى بعده. فسمع قوله الحسين (عليه السّلام)، فقال له: «رحمك الله. أنت في حلّ من بيعتي، فاعمل في فكاك ابنك». قال: أكلتني السباع حيّاً إن فارقتك. قال: «فاعط ابنك هذه الأثواب البرود يستعين بها في فداء أخيه»، فأعطاه خمسة أثواب قيمتها ألف دينار(١) ... إلى غير ذلك ممّا يجده الناظر في تاريخ هذه النهضة المقدّسة ممّا يشهد بالتزام المبادئ والدين والخلق الرفيع فيها.
وهو الذي جرى عليه أئمّة أهل البيت (صلوات الله عليهم) في جميع مواقفهم ونشاطاتهم، وعُرف عنهم، وكان سبباً في فرض احترامهم على العدو والصديق، بل تقديسهم لهم.
على مدّعي الإصلاح التزام سلامة آليّة العمل
فاللازم على مدّعي الإصلاح التمسّك بذلك، والحفاظ عليه.
أوّلاً : لأنّ ذلك هو اللازم في نفسه، لشرف تلك المبادئ، وسمو تلك المثل.
وثانياً : لتكون الوسيلة مناسبة للهدف؛ حيث يكشف ذلك عن صدق مدّعي الإصلاح في دعواه، وسلامة هدفه وغايته.
وأمّا ما قد يُدّعى من أنّ ذلك قد يُعيق عملية الإصلاح؛ حيث قد يستغل الطرف الآخر ذلك من أجل الالتفاف على المصلح، والقضاء على مشروعه كما حصل كثيراً.
____________________
١ - تاريخ دمشق ١٤/١٨٢ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، واللفظ له، تهذيب الكمال ٦/٤٠٧ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، ترجمة الإمام الحسين (عليه السّلام) من طبقات ابن سعد/٧١ ح ٢٩٢.
فهو مرفوض أوّلاً؛ لأنّ التخلّي عن مشروع الإصلاح والالتزام بتعذّره، أو الاكتفاء منه بالقليل الممكن مع الحفاظ على المبادئ المذكورة أهون بكثير من الخروج في وسيلة الإصلاح عن الدين والمبادئ الشريفة والمثل السامية، كما قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): «لا أرى إصلاحكم بفساد نفسي»(١) .
وثانياً : لأنّ الحفاظ في الأوقات الحرجة على الدين والمبادئ الشريفة هو بنفسه إصلاح للمجتمع على الأمد البعيد؛ لأنّه يذكر بالدين والمبادئ المذكورة، وينّبه إلى أهميته، وإلى أنّ هذه المبادئ عملية قابلة للتطبيق، ولا يتخلّى عنها أهلها مهما كلّفتهم من تضحيات، وليست هي فرضيات صرفة، أو شعارات برّاقة لإقناع الناس واصطياد الأتباع.
وذلك في حقيقته حثّ عملي عليها يوجب تركزها في النفوس، وله أعظم الأثر في إصلاح المجتمع ورفع مستواه الخلقي.
لا يتابع مدّعي الإصلاح مع عدم سلامة آليّة العمل
ويترتب على ما ذكرنا أنّه لا ينبغي لعموم الناس التجاوب مع مدّعي الإصلاح إذا لم يلتزم بالمبادئ والمثل، وسوّغ لنفسه الخروج عليها.
لأنّ ذلك يكشف إمّا عن كذبه في دعوى الإصلاح، أو عن ضعفه أمام المغريات والمبرّرات المزعومة بنحو لا يؤمَن عليه من الانحراف في نهاية المطاف، فيكون التعاون معه تغريراً وتفريطاً لا يُعذر صاحبه فيه.
والحذر ثمّ الحذر من أن تجرّ شدّة الانفعال من الفساد، والرغبة العارمة في الإصلاح إلى مواقف انفعالية عاطفية يفقد الإنسان بها رشده، فيتخلّى في سبيل
____________________
١ - أنساب الأشراف ٣/٢١٥ غارة بسر بن أبي أرطاة القرشي، الإرشاد ١/٢٧٣، الأمالي - للمفيد/٢٠٧، بحار الأنوار ٣٤/١٤.
تحقيق هدفه عن المبادئ الشريفة، والتعاليم الدينية القويمة بأعذار ومبرّرات ما أنزل الله بها من سلطان، فيكون قد أعطى باليمين ما أخذه باليسار.
بل قد يزيد في الفساد؛ لأنّه إذا فتحت الباب للأعذار والمبرّرات صعب غلقها أو تحجيمها وتحديدها، وكلّما استمر الإنسان على ذلك زاد هو وكلّ مَنْ هو على خطّه جرأة على الخروج عن المبادئ الشريفة والتعاليم السامية حتى يتمحّض مشروعه في الجريمة.
على أنّه ربما يفشل في مشروعه، ويبقى عليه تبعة الخروج في سبيل تحقيق هدفه عن الموازين الدينية والعقلية والأخلاقية.
مع إنّ تبرير الجريمة في نفسه من أجل الغاية من قِبَل الشخصيات ذات الوجود الاجتماعي المحترم موجب لتخفيف حدّة الجريمة في نفوس العامّة، وضعف الرادع الوجداني عنها تدريجاً، فيسهل ارتكابها، وبذلك تضيع معالم الحقّ، وهو من أعظم الجرائم في حق المجتمع.
وما أكثر ما استغلّ المصلحيون والانتهازيون في سبيل تحقيق مصالحهم وأهدافهم الجهنمية تأجيج العواطف ضدّ الفساد، والدعوة للإصلاح؛ من أجل إغفال أتباعهم عن واقعهم المشبوه وسلوكهم المشين، فسار الناس وراءهم متغافلين عن كلّ ما يصدر منهم، ثمّ لم ينتبهوا إلّا بعد فوات الأوان حيث لا ينفع الندم. ونسأل الله سبحانه وتعالى العصمة والسداد.
المقام الثاني
في النتائج
سبق أن أشرنا إلى أنّ تجربة أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في السلطة كشفت عن تعذّر إصلاح المجتمع الإسلامي بإقامة حكم يطبّق الإسلام عملياً بنحو كامل.
لكنّ اهتمام شيعة أهل البيت (صلوات الله عليهم) والموالين لهم في الكوفة بالإصلاح، ومعاناتهم من الفساد، وشعورهم بالتقصير آنفاً إزاء أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسّلام) كلّ ذلك جعلهم يستسهلون الصعاب في سبيل الإصلاح المذكور، وأفقدهم النظرة الموضوعية في الموازنة بين قوى الخير والشرّ، وفي التمييز بين ذوي المبادئ والتصميم حتى النفس الأخير، وغيرهم ممّنْ ينهار إذا جدّ الجدّ وضاقت الأمور، أو يكون انتهازياً في مواقفه من أوّل الأمر.
وقد جعلهم ذلك يترددون على الإمامين الحسن والحسين (صلوات الله عليهم) في عهد معاوية يحاولون حملهما على الخروج عليه، لكنّهما (عليهما السّلام) لم يستجيبا لهم؛ لعدم تحقّق الظرف المناسب على ما يأتي التعرّض له إن شاء الله تعالى.
حتى إذا انتهى عهد معاوية تخيّلوا إمكان تحقيق حلمهم في الإصلاح؛ فاندفعوا في سبيل ذلك، وتحمّلوا مسؤولية تعهّدهم للإمام الحسين (صلوات الله عليه)، وحملهم له على تلك النهضة المقدّسة، وتبعات تقصيرهم في حقّه، والعدوان الذي حصل عليه وعلى مَنْ معه.
وإذا كان الإمام الحسين (صلوات الله عليه) قد استجاب لهم من أجل التضحية لصالح الدين - كما أوضحناه فيما سبق - فإنّ ذلك لم يكن هو مشروعهم الذي تحرّكوا من أجله، بل حاولوا إقامة حكم إسلامي أصيل يطبّق الإسلام عملياً بالوجه الكامل.
كشفت فاجعة الطفّ عن تعذّر إصلاح المجتمع بالوجه الكامل
وقد كشفت فاجعة الطفّ أخيراً عن تعذّر ذلك، وأكّدت ما كشفت عنه تجربة أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) من قبل.
وكلّما امتدّ الزمن كان ذلك أولى بالتعذّر؛ فإنّ ظرف نهضة الإمام الحسين (صلوات الله عليه) يتميّز عمّا بعده من العصور بأمور:
الأوّل : شخص الإمام الحسين (صلوات الله عليه) الذي هو أعرف الناس بحقيقة الإسلام، مع مؤهلاته الشخصية الأخرى من حكمة واستقامة، وقوّة وتصميم، وصلابة موقف... إلى غير ذلك.
مضافاً إلى أنّه خامس أصحاب الكساء (عليهم السلام)، وقد فرض احترامه على عموم المسلمين، وهم يرونه في قرارة نفوسهم الرجل الأوّل فيهم كما سبق.
الثاني : القرب من العهد النبوي؛ حيث يوجد بقيّة من كبار الصحابة والتابعين الذين هم على علم بكثير من الحقائق قد تكون خفيت بعد ذلك.
الثالث : التدهور السريع نتيجة الانحراف، خصوصاً في العهد الأموي الذي تمادى فيه الانحراف لصالح مَنْ يعرف عنهم المسلمون أنّهم أعداء الإسلام، حيث صدمهم ذلك، وعظم وقعه عليهم.
أمّا بعد ذلك فيهون ما استصعبوه أوّلاً؛ إذ كلّما طال الزمن وتعاقبت الأجيال يخفّ وقع الانحراف والتدهور، ويألفه المجتمع حتى يكون جزءاً من
كيانهم، ولا يستفزّهم.
الرابع : وجود نخبة صالحة قد تعرّفت على الحقيقة الكاملة من عهد أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)، وصمّمت على التضحية في سبيل هذه الحقيقة.
ولا نعني بذلك كلّ مَنْ كتب إلى الإمام الحسين (صلوات الله عليه)، أو بايع؛ إذ كثير منهم انتهازيون قد قاموا بذلك لتخيّلهم نجاح الإمام (عليه السّلام) في الاستيلاء على السلطة، وكثير منهم همج رعاع ينعقون مع كلّ ناعق.
بل نعني به مَنْ كان مصمّماً على التضحية عن جدّ وإخلاص، وهم كثيرون نسبياً؛ سواء مَنْ ضحى بالفعل، أم مَنْ لم يضحِ؛ إمّا لأنّه منع من الوصول للإمام الحسين (عليه السّلام) لسجن، أو لقطع الطرق وجعل المراصد - كما أشرنا إليه في المقدّمة -، أو لأنّ عزمه قد ضعف عندما جدّ الجدّ، أو عندما يئس من انتصار الإمام الحسين (عليه السّلام) عسكرياً.
ومع كلّ هذه الأمور الأربعة لم يتسنَّ للنهضة الشريفة النجاح العسكري؛ بسبب غشم السلطة، وفساد المجتمع، وتخاذله أمام الغشم المذكور.
كما قال الإمام الحسين (صلوات الله عليه) في خطبته في الطريق أو حينما نزل كربلاء: «الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درّت معايشهم، فإذا محصّوا بالبلاء قلّ الديانون»(١) .
وقد تجاهلت السلطة كلّ الحواجز والمثبّطات، وقامت بهذه الجريمة النكراء بأبعادها المتقدّمة، وتبعها مَنْ تبعها، وكُمّت الأفواه، بين الخوف والأطماع.
وذلك كافٍ لأن يكون عبرة ودليلاً على تعذّر الإصلاح الكامل؛ إذ لا ينتظر وجود قائد أكفأ من الإمام الحسين (صلوات الله عليه)، ولا وجود أُناس
____________________
١ - تقدّمت مصادره في/٣٦.
أصلح ممّنْ كان في عصره، ولا تهيؤ ظرف أحسن من ظرفه بحسب الوضع الطبيعي، بل كلّما استمر الزمن زاد الفساد وألِفه الناس.
لا ينبغي الاغترار باندفاعات الناس العاطفية
ولا ينبغي الاغترار بمواقف الناس العاطفية حتى لو صدقت؛ نتيجة اكتوائهم بآلام الفساد وتعطشهم للإصلاح؛ لأنّ ذلك قصير الأمد، ثمّ لا بدّ من التراجع نتيجة العوامل المختلفة من خوف أو رجاء، أو ملل أو وهن أمام المتاعب والعقبات التي تقف في طريق الإصلاح... إلى غير ذلك.
ولو فرض تحقّق فرصة لانتصار المشروع عسكرياً في ظروف استثنائية، فيتعذّر الاحتفاظ به مع الحفاظ على المبادئ، بل لا بدّ إمّا من الإجهاز عليه أخيراً - كما حدث في تجربة أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) - أو الانحراف به تدريجاً حتى يُمسخ؛ نتيجة فساد المجتمع، وتكالب قوى الشرّ والطغيان كما حصل في كثير من المحاولات.
ينحصر الأمر بمحاولة الإصلاح النسبي
ومن هنا ينحصر الأمر بالإصلاح النسبي الراجع لتخفيف الفساد؛ إمّا على الصعيد الفردي بالتربية الصالحة، والموعظة الحسنة، والتثقيف الديني السليم، وإمّا على الصعيد الاجتماعي العام بتخفيف نسبة الفساد فيه ولو إلى أمد قصير؛ فإنّ الميسور لا يُترك بالمعسور، وما لا يُدرك كلّه لا يُترك كلّه.
نعم، لا بدّ:
أوّلاً : من إحراز المبرّر الشرعي للتحرّك.
وثانياً : من الموازنة الموضوعية بين الخسائر التي تقع في طريق العمل،
والفوائد المترتبة عليه بحيث يكون العمل مثمراً ولازماً أو سائغاً.
وذلك يختلف باختلاف الظروف والمقارنات، كما تختلف فيه وفي أساليبه الأنظار والقناعات، ولكلّ وجهة نظره، وهو يتحمّل مسؤولية عمله من دون أن يتحمّل الإسلام سلبيات ذلك، والحساب على الله (عزّ وجلّ).
وثالثاً : من الإصحار بالهدف على حقيقته، وعدم إطلاق الدعاوى العريضة، والمواعيد الكبيرة من أجل جمع الأعوان والتغرير بالناس. كلّ ذلك للحفاظ على سلامة آليّة العمل كما سبق.
وهذه الحقيقة وإن كانت مرّة إلّا إنّها واقع قائم لا مفرّ منه، ويجب الاعتراف به؛ نتيجة النظرة الموضوعية، ثمّ التعامل مع هذا الواقع بحكمة ورويّة، وبعد نظر بعيداً عن النظرة العاطفية، والمواقف الانفعالية.
وقد سبق أنّ ذلك لم يكن يخفى على الإمامين الشهيدين أمير المؤمنين والحسين (صلوات الله عليهما)، وأنّهما لم يقدما على ما أقدما عليه من أجل تحقيق العدل المطلق، وإقامة النظام الإسلامي الأكمل، بل كان هدفهما رضى الله سبحانه وتعالى والقيام بتكليفهما.
وقد ظهر لنا من ثمرات تحرّكهما وجهادهما كبح جماح الانحراف في الدين، وتخفيف الفساد بظهور صوت الحقّ المنكر عليه، وإقامة الحجّة على الحقّ، وإسماع دعوته، وقطع العذر على مَنْ يخرج عنه... إلى آخر ما تقدّم.
مسألة الأئمة المتأخرين عليهم السلام للسلطة
وإذا كان شيعة أهل البيت قبل فاجعة الطفّ لا يستوعبون هذه الحقيقة، ولا يذعنون بتعذّر الإصلاح الكامل وتعديل مسار السلطة في الإسلام؛ لقلّة تجربتهم وشدّة إنكارهم للظلم، وعظيم ما قاسوه منه، واغترارهم بمواقف
الناس الانفعالية، وبتعهّدهم بالانتصار للحق، وبالثبات على ذلك.
فمن القريب جدّاً أن تكون صدمتهم بفاجعة الطفّ الفظيعة - بأبعادها المأساوية المتقدّمة - وما ظهر من نقض الناس للعهود، وتخاذلهم إذا جدّ الجدّ قد أعادت لكثير منهم رشدهم.
فأخذوا يتقبّلون من الأئمّة من ذريّة الإمام الحسين (صلوات الله عليه وعليهم) إصرارهم على الموقف المسالم للسلطة، والرافض للخروج عليها بالسيف، وإعلانهم (عليهم السّلام) عن أنّ قيام دولة الحقّ إنّما يكون بظهور خاتمهم القائم المنتظر (عجّل الله تعالى فرجه الشريف).
حتى صار ذلك شعاراً للأئمّة (صلوات الله عليهم)، وعرفه عنهم الجمهور، وتميّزوا به عن غيرهم - من الفاطميين وغيرهم - ممّنْ يدعو للثورة، والكفاح المسلّح ضدّ الظالمين، وإقامة نظام بديل عن نظامهم.
وقد صار ذلك سبباً لتعاطف عامّة الناس معهم (عليهم السّلام)، وشعورهم بمظلوميتهم عند تعرّضهم لضغط السلطة وتنكيلها بعد أن لم يكونوا بصدد منافستها والخروج عليها.
ولاسيما مع ما لهم (صلوات الله عليهم) من الكرامة والاحترام في نفوس المسلمين عامّة؛ نتيجة مقامهم الرفيع في النسب والعلم والعمل.
ولا يظهر الإنكار على الأئمّة (عليهم السّلام) من شيعتهم، أو التململ من الموقف المذكور إلّا بصورة فردية انفعالية يسهل عليهم (عليهم السّلام) تجاهلها أو الردّ عليها، وإفهام مَنْ يصدر منه ذلك بخطئه، وسوء تقديره للأمور.
ولاسيما بعد أن تبلور مفهوم عصمة الإمام، ووجوب التسليم له. وقد حفظ لنا التراث الشيعي كثيراً من مفردات ذلك.
حديث سدير الصيرفي
وقد يحسن بنا أن نذكر هنا حديث سدير الصيرفي، قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السّلام)، فقلت له: والله ما يسعك القعود. فقال: «ولِمَ يا سدير؟». قلت: لكثرة مواليك وشيعتك وأنصارك. والله لو كان لأمير المؤمنين (عليه السّلام) ما لَكَ من الشيعة والأنصار والموالي ما طمع فيه تيم وعدي. فقال: «يا سدير، وكم عسى أن يكونوا؟». قلت: مئة ألف. قال: «مئة ألف؟!». قلت: نعم، ومئتي ألف. قال: «مئتي ألف؟!». قلت: نعم، ونصف الدنيا. قال: فسكت عنّي. ثمّ قال: «يخفُّ عليك أن تبلغ معنا إلى ينبع؟». قلت: نعم. فأمر بحمار وبغل أن يُسرج... فمضينا، فحانت الصلاة، فقال: «يا سدير، انزل بنا نصلّي». ثمّ قال: «هذه أرض سبخة لا تجوز الصلاة فيها». فسرنا حتى صرنا إلى أرض حمراء، نظر إلى غلام يرعى جداءً، فقال: «والله يا سدير، لو كان لي شيعة بعدد هذه الجداء ما وسعني القعود». ونزلنا وصلّينا، فلمّا فرغنا من الصلاة عطفت على الجداء فعددتها فإذا هي سبعة عشر(١) .
ومن الطبيعي أن يكون مراده (عليه السّلام) من الشيعة هنا الخلّص ذوي الثبات والتسليم، والتصميم على الوجه الأكمل الذين لا تزعزعهم المحن والبليات، ولا تزيلهم الشبهات والمغريات.
وقد يشير إلى ذلك حديث أبي مريم عن الإمام الباقر (عليه السّلام) قال: «قال أبي يوماً وعنده أصحابه: مَنْ منكم تطيب نفسه أن يأخذ جمرة في كفّه، فيمسكها حتى تطفُ؟». قال: «فكاع الناس كلّهم ونكلوا، فقمت وقلت: يا أبة أتأمر أن أفعل؟ فقال: ليس إيّاك عنيت؛ إنّما أنت منّي وأنا منك، بل إيّاهم أردت [ قال: ] وكرّرها ثلاثاً. ثمّ قال: ما أكثر الوصف، وأقلّ الفعل. إنّ أهل الفعل قليل، إنّ أهل الفعل قليل، وإنّا لنعرف أهل الفعل والوصف معاً، وما كان هذا منّا
____________________
١ - الكافي ٢/٢٤٢ - ٢٤٣ ح ٤.
تعامياً عليكم، بل لنبلوا أخباركم، ونكتب آثاركم». فقال: «والله لكأنّما مادت بهم الأرض حياء ممّا قال...، فلمّا رأى ذلك منهم قال: رحمكم الله، فما أردت إلّا خيراً. إنّ الجنّة درجات، فدرجة أهل الفعل لا يدركها أحد من أهل القول، ودرجة أهل القول لا يدركها غيرهم». قال: «فوالله، لكأنّما نشطوا من عقال»(١) .
وعلى ذلك يجري قوله تعالى:( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثمّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً ممّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً * وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُواْ مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أنّهم فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيت ) (٢) .
نعم، قد تعرّض الأئمّة (صلوات الله عليهم) للإنكار عليهم ممّنْ يتبنّى خطّ الثورة من العلويين وغيرهم، إلّا إنّهم (عليهم السّلام) لم يكترثوا بذلك بعد رضوخ شيعتهم لهم، وتقبّلهم لموقفهم، ولاسيّما بعد ظهور فشل محاولات الثورة والإصلاح الكثيرة عسكرياً، أو عملياً بانحراف الثورة حين قيامها أو بعد نجاحها.
والحاصل: إنّ فاجعة الطفّ قد خفّفت من ضغط الدعوة للثورة على سلطان الجور عن الأئمّة (صلوات الله عليهم)، وسهّلت عليهم إقناع شيعتهم بعدم الجدوى فيه، وانتظار الفرج بقيام الحجّة المهدي المنتظر (صلوات الله عليه وعجّل الله فرجه).
وهذه فائدة مهمّة لفاجعة الطفّ حيث سهّلت على الأئمّة (عليهم السّلام) بناء الشيعة ثقافياً كما يريدون، بعيداً عن الضجيج والعجيج، وهي في الحقيقة من جملة الثمرات الدينية لفاجعة الطفّ تضاف لما سبق في الفصل الأوّل.
____________________
١ - الكافي ٨/٢٢٧ - ٢٢٨ ح ٢٨٩.
٢ - سورة النساء/٦٥ - ٦٦.
دعوى أنّ ذلك لا يتناسب مع قابلية الإسلام للتطبيق
هذا وقد يدّعي المدّعي أنّ ذلك لا يتناسب مع ما نعتقده - نحن وعامّة المسلمين - من ابتناء التشريع الإسلامي على حكم الإسلام في الأرض؛ وما ذلك إلّا لقابلية نظام الإسلام للتطبيق بوجه كامل من أجل إصلاح المجتمع، وتطهيره من الفساد، وتعميم العدل، فكيف يدّعى تعذّر ذلك، خصوصاً في عصر حضور الأئمّة (صلوات الله عليهم)؟!
دفع الدعوى المذكورة
والجواب عن ذلك: إنّ من تتمّة نظام الإسلام العظيم أن يكون المشرف على تطبيقه بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم الأئمّة من أهل البيت (صلوات الله عليهم)، المأمونين عليه نتيجة عصمتهم، والمحكمين فيه نتيجة وجوب موالاتهم وطاعتهم، وبذلك كمال الدين وتمام النعمة.
ولو أنّ الصحابة الأوّلين من المهاجرين والأنصار أجمعوا على ذلك، واتّحدت كلمتهم، وتسلّم أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) السلطة بناء على ذلك وإقراراً له لاختلف كيان الإسلام عمّا انتهى إليه بسبب الانحراف.
إذ يُقرّ قولاً وعملاً بنحو إجماعي عند المسلمين نظام الخلافة حينئذٍ على ما أراده الله تعالى من خلافة الإمام المعصوم المنصوص عليه، بدءاً بأمير المؤمنين (صلوات الله عليه)، وهو الذي كان يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الضاربة، وسيفه الصارم في جهاده الطويل، والمبلّغ عنه والناطق باسمه.
والذي هو امتداد طبيعي لوجوده صلى الله عليه وآله وسلم الشريف في كونه عميداً لبني هاشم، القبيلة ذات المقام الرفيع في نفوس العرب الذي زاد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أضعافاً كثيرة.
كما إنّه (عليه السّلام) امتداد طبيعي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوّة شخصيته (عليه السّلام) وصلابته وهيمنته، وفي علمه وعمله، وفي مبادئه ومثاليته.
ويترتّب على ذلك أمور في غاية الأهمية:
الأوّل : انصياع العرب لأمير المؤمنين (عليه السّلام) بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتجنّب المسلمون كثيراً من الحروب التي سمّيت بحروب الردّة، أو جميعها.
كما يناسبه قول سلمان الفارسي حينما بويع أبو بكر: أصبتم ذا السنّ منكم، وأخطأتم أهل بيت نبيّكم. لو جعلتموها فيهم ما اختلف عليكم اثنان، ولأكلتموها رغداً(١) ، وقول أبي ذرّ: لو جعلتم هذا الأمر في أهل بيت نبيّكم لما اختلف عليكم اثنان(٢) .
إذ الظاهر أنّ كثيراً من تلك الحروب أو كلّها إنّما كانت من أجل تثبيت السلطة الجديدة المهزوزة دينياً؛ لعدم كونها بعهد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واجتماعياً؛ لاستهانة العرب بأبي بكر وقبيلته، ولسقوط هيبة الإسلام باختلاف المسلمين وانشقاقهم على ما أوضحناه في جواب السؤال الرابع من الجزء الثاني من كتابنا (في رحاب العقيدة ).
الثاني : قطع آمال الآخرين في السلطة إلى الأبد، ويتجنّب المسلمون الصراع عليه، ذلك الصراع الذي فرّقهم ونخر في كيانهم، بل دمّرهم.
الثالث : تحجيم دور المنافقين وحديثي الإسلام في إدارة الأمور، وفي نشر مفاهيمهم، وقطع الطريق عليهم من أجل قضاء مآربهم الخبيثة على حساب الإسلام.
الرابع : قوّة نفوذ السابقين من الصحابة المعروفين بقوّة الدين، والإخلاص والأثر الحميد في الإسلام، والتابعين لهم بإحسان من ذوي الإيمان والتقوى
____________________
١ - شرح نهج البلاغة ٢/٤٩، و٦/٤٣.
٢ - شرح نهج البلاغة ٦/١٣، واللفظ له، و٢/٤٩، بحار الأنوار ٢٨/١٩٥.
والالتزام العملي.
وبذلك يتجنّب الإسلام كثيراً من السلبيات والمفارقات التي تقدّم منّا التعرّض لبعضها في حديثنا هذا.
ومن الطبيعي حينئذ أن تسير عجلة الإسلام بتعاليمه الكاملة ومثله السامية على الطريق الواضح من دون أي انحراف أو تحوير أو وهن، ويتجسّد بواقعه الثقافي والعملي على ما أراده الله (عزّ وجلّ) كما تضمّنت ذلك النصوص الكثيرة.
فإذا تمّت الفتوح في عهد هذا الإسلام الأصيل وهذه القيادة الفذة، والجماعة الصالحة، واتّسعت رقعته، وجاءت بسببها الغنائم والخيرات، والعزّة والكرامة قوي هذا الإسلام وارتفع شأنه، وتركّز في النفوس وتجذّر في أعماقها.
وبذلك يقوم كيان الإسلام على الاستقامة والصلاح مهما اتسع وانتشر من دون أن يكون هناك ما يدعو للخروج عليه، أو الانحراف به.
صلاح المجتمع مدعاة للتسديد والفيض الإلهي
ولاسيما أنّ المجتمع المذكور يكون حينئذ مورداً للفيض الإلهي، كما قال الله تعالى:( وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ ) (١) ، وقال (عزّ وجلّ):( وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ * وَلَوْ أنّهم أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّن رَّبِّهِمْ لأكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم... ) (٢) .
وقد تقدّم قريباً في كلام سلمان الفارسي (رضي الله عنه) ما يناسب ذلك، ونحوه في كلام له آخر(٣) . وفي كلام له ثالث: لو بايعوا علياً لأكلوا من فوقهم، ومن تحت
____________________
١ - سورة الأعراف/٩٦.
٢ - سورة المائدة/٦٥ - ٦٦.
٣ - المصنّف - لابن أبي شيبة ٨/٥٨٦ كتاب المغازي، ما جاء في خلافة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه).
أرجلهم(١) . وفي كلام أبي ذرّ: أما لو قدّمتم مَنْ قدّم الله، وأخّرتم مَنْ أخّر الله، وأقررتم الولاية والوراثة في أهل بيت نبيّكم لأكلتم من فوق رؤوسكم، ومن تحت أقدامكم(٢) .
ومن الظاهر أنّ الفيض الإلهي المذكور يقلل من فرص الخلاف والشقاق، ومن الخروج على السلطة الشرعية؛ لفقد المبرّر له، ورفض المسلمين لذلك حينئذٍ.
بل قد ورد في كلام غير واحد من أهل البيت (صلوات الله عليهم) ووجوه الصحابة القطع بعدم تحقّق الخلاف والشقاق حينئذٍ، كما يناسبه ما سبق في كلامي سلمان وأبي ذرّ.
وقالت الصديقة فاطمة الزهراء (صلوات الله عليه) في خطبتها الكبرى: «فجعل الله الإيمان تطهيراً لكم من الشرك، والصلاة تنزيهاً لكم عن الكبر...، وطاعتنا نظاماً للملّة، وإمامتنا أماناً للفرقة»(٣) .
وقال عبد الله بن جعفر في حديث له مع معاوية: فإنّ هذه الخلافة إن أُخذ فيها بالقرآن فأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وإن أُخذ فيها بسُنّة رسول الله فأولوا رسول الله...، وأيم الله لو ولّوه بعد نبيّهم لوضعوا الأمر في موضعه؛ لحقه وصدقه، ولأطيع الرحمن وعصي الشيطان، وما اختلف في الأُمّة سيفان(٤) ... إلى غير ذلك ممّا يدلّ على أنّ الأُمّة لو لم تنحرف من أوّل الأمر لاستمرت في استقامتها وتماسكها.
____________________
١ - أنساب الأشراف ٢/٢٧٤ أمر السقيفة.
٢ - تاريخ اليعقوبي ٢/١٧١ أيام عثمان.
٣ - راجع ملحق رقم (١).
٤ - الإمامة والسياسة ١/١٤٠ ما تكلم به عبد الله بن جعفر، جمهرة خطب العرب ٢/٢٤٧ الباب الثالث، الخطب والوصايا في العصر الأموي، خطب بني هاشم وشيعتهم وما يتصل بها، خطبة عبد الله بن جعفر.
ولو فرض أن سوّلت بعض النفوس لأصحابها بذلك كان خارجاً عن جماعة المسلمين محارباً من قبلهم، لا مجال لتبرير موقفه بعد اتفاقهم على وجوب طاعة الإمام وعصمته اللذين لا مجال معهما للاجتهاد والاختلاف.
ولاسيما بعد إدراكهم خير ذلك وبركته بنحو يقتضي تجذّر الاستقامة والانقياد للحق في نفوسهم، والاهتمام بالحفاظ عليه، والدفاع عنه.
إنّما يتعذّر الإصلاح الكامل بعد حصول الانحراف
وإنّما قلنا آنفاً بتعذّر الإصلاح التام وتطبيق حكم الإسلام كاملاً من أجل الواقع الذي حصل حيث انحرفت من اليوم الأوّل مسيرة السلطة في الإسلام، فترتّب على ذلك التلاعب في الدين، وإبعاد المخلصين، ونفوذ المنافقين، واختلاف الأُمّة وانشقاقها على نفسها، وطمع في السلطة مَنْ ليس أهلاً له من دون ضابط ولا وازعٍ حتى انتهى الأمر إلى أعداء الإسلام والمسلمين، والموتورين منه ومنهم.
ثمّ ظهرت الفرق في الأُمّة، وانشقّت على نفسها، وصار لكلّ فرقة دينها الذي تختص به، ومقاييسها التي تجري عليها، وتجذّر في أعماقها بحيث يصعب التحرّر منها، والفحص عن الحقّ بموضوعية خالصة.
وفتح باب الاجتهاد والتشبّث بالمبرّرات للخروج عن النصّ، ومرضت النفوس، وتعوّدت على اللف والدوران، والبغي والعدوان، وظهرت كوامن النفوس الشريرة، وشيب الحقّ بالباطل.
زيادة الأمر تعقّداً في عصر الغيبة
ويزيد الأمر تعقّداً في عصر الغيبة؛ حيث لا معصوم ناطق يرعى بالمباشرة
الدين والدولة، وغاية ما نملك مجتهدون معرّضون للخطأ، وهم يختلفون في معرفة الحكم الشرعي وتحديده، وفي الطريق الأمثل لتطبيقه نسبياً، ولا يملك أي منهم القدرة على إقناع الآخرين بما أدّى إليه اجتهاده، وليس له الحقّ في فرض قناعته على غيره.
مضافاً إلى ما أفرزته التداعيات السابقة من نظريات مناهضة للدين يروّج لها الأعداء والنفعيون، وعقبات وألغام يزرعونها في طريق العاملين المخلصين الثابتين الذين هم أقلّ القليل.
ويدعمها في ذلك قوى هائلة ظاهرة وخفية تحاول أن تمسك بزمام الأمور، لا يهمّها تدمير المجتمع الإنساني في سبيل مصالحها الخاصة، ومن أجل تنفيذ مخططاتها الجهنّمية.
وكلّما امتدّ الزمن بالمجتمع الإنساني المريض زادت الأوضاع سوءاً والأمور تعقّداً، وتضاعفت المشاكل والسلبيات، إلّا إن تتدخل العناية الإلهية بنحو خاص، ولا مفرّج إلّا الله (عزّ وجلّ) وإليه يرجع الأمر كلّه.
لا يسقط الميسور من الإصلاح بالمعسور
نعم، لا يسقط الميسور من الإصلاح بالمعسور، وما لا يُدرك كلّه لا يُترك كلّه، ولكلّ وجهة نظره، والله سبحانه وتعالى من وراء القصد.( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ) (١) .
وعلى كلّ حال فذلك كلّه ليس لقصور في النظام الإسلامي الرفيع، ولا في التشريع الإلهي القويم، بل لتقصير الأُمّة في واجبها من اليوم الأوّل حيث فسحت المجال للانحراف، وغضّت الطرف عنه، ولم تقم بواجبها في إنكار
____________________
١ - سورة العنكبوت/٦٩.
المنكر والاستجابة للإمام المعصوم (صلوات الله عليه) من أجل تعديل المسار وإصلاح الأوضاع.
فتبوء هي بذنبها، وتتحمّل مسؤولية عملها من دون أن يتحمّل الإسلام ولا رموزه العظام شيئاً من ذلك، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.
ونسأله (عزّ وجلّ) التسديد والتوفيق، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونعتصم به من الشيطان الرجيم، ومن مضلات الفتن، إنّه أرحم الراحمين، وولي المؤمنين، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
المقصد الثالث
في توقيت فاجعة الطفّ
من الظاهر أنّ الأئمّة من أهل البيت (صلوات الله عليهم) بأجمعهم يشتركون في مسؤولية رعاية الدين والجهاد في سبيل صلاحه وحمايته، وظهور دعوته وحجّته، ولا يختص الإمام الحسين (صلوات الله عليه) بذلك.
فلا بدّ أن يكون انفراده من بينهم بنهضته التي انتهت بفاجعة الطفّ لاختصاصه (عليه السّلام) بظروف، ودواعي ألزمته بذلك لم تتحقّق لهم (عليهم السّلام)؛ لظهور أنّ عصمتهم بأجمعهم (صلوات الله عليهم) تستلزم قيام كلّ منهم بوظيفته المناسبة لظروفه التي يعيشها، وتكليفه الذي يختص به.
وقد أكّدت النصوص الشريفة الواردة عنهم (عليهم السّلام) على أنّ كلاً منهم إنّما يقوم بوظيفته المعهودة له من قبل الله تعالى، وقد سبق ذكر بعضها في مقدّمة هذا الكتاب، والله سبحانه وتعالى هو العالم بما يقتضيه كلّ ظرف وزمان.
وهذا على الإجمال أمر لا إشكال فيه، وإنّما نحاول هنا التعرّف على ما امتازت به ظروف نهضة الإمام الحسين (صلوات الله عليه) - بحيث لزمه النهوض ولم يسعه القعود - حسبما يتيسّر لنا، ونرجو أن نوفّق في ذلك، فنقول:
بالتأمّل فيما ذكرناه في المقصدين السابقين يتّضح كثير من وجوه الفرق
بين ظروفه وظروف بقيّة الأئمّة (صلوات الله عليهم أجمعين)، إلّا إنّه يحسن بنا هنا التعرّض بتفصيل لما ندركه في وجه اختلاف مواقفهم.
والكلام..
تارة : في أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسّلام).
وأُخرى : في الإمام الحسن السبط (صلوات الله عليه).
وثالثة : في الأئمّة من ذرية الحسين (عليهم السّلام)، وذلك في فصول ثلاثة.
الفصل الأوّل
في موقف أمير المؤمنين (عليه السّلام)
بعد خروج السلطة عن موضعها الذي وضعها الله تعالى فيه، وانحراف مسيرة نظام الحكم الإسلامي، فأمير المؤمنين (صلوات الله عليه) - فيما يبدو - كان معنيّاً بأمرين لهما أهمية كبرى في الحفاظ على دعوة الإسلام الحقّ، وبقائها للأجيال، وتبليغهم بها.
اهتمام أمير المؤمنين (عليه السّلام) بحفظ كيان الإسلام العام
الأوّل : حفظ كيان الإسلام العام الذي بذل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمناصحون من أصحابه جهوداً جبّارة من أجله؛ لتبقى دعوة الإسلام الشاملة بين مجموعة كبيرة من الناس ذات قوّة وعدد بحيث تسعى لنشره والدفاع عنه، ولو من أجل مصالحها وامتيازاتها، وقد ورد أنّ الله (عزّ وجلّ) ينصر هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم(١) .
كلّ ذلك من أجل أن يتسنّى للأمم البعيدة سماع دعوته، والتعرّف عليه،
____________________
١ - تهذيب الأحكام ٦/١٣٤، مستدرك الوسائل ١١/١٥، صحيح ابن حبان ١٠/٣٧٦ كتاب السير، ذكر البيان بأن الأمراء وإن كان فيهم ما لا يحمد فإنّ الدين قد يؤيد بهم، السنن الكبرى - للنسائي ٥/٢٧٩ كتاب السير، إنّ الله ليؤيد الدين بالرجل الفاجر، مسند أحمد ٥/٤٥ حديث أبي بكرة، مجمع الزوائد ٥/٣٠٢ كتاب الخلافة، باب فيمَنْ يؤيد بهم الإسلام من الأشرار، المعجم الأوسط ٢/٢٦٩، و٣/١٤٢، وغيرها من المصادر الكثيرة.
والنظر فيه، والاهتداء به، برغم السلبيات التي يفرزها الانحراف؛ ليكون الدخول في الإسلام - بكيانه العام - مفتاحاً لمعرفة الإسلام الأصيل، والمذهب الحقّ بعد الاطلاع على اختلاف المسلمين، والاستئناس بتعاليمهم وأدلتهم.
أمّا مع انهيار كيان الإسلام العام - بالردّة العامّة ونحوها - فلا يتيسّر لتلك الأمم الاطلاع على الدين الحقّ، والفرقة الناجية حتى لو بقيت الثلّة الصالحة من حملته؛ لقلتهم وعجزهم عن اكتساح القوى الهائلة المناهضة للإسلام، والاصطدام به، والانتشار في فجاج الأرض.
اهتمامه (عليه السّلام) بالحفاظ على حياته وحياة الثلّة الصالحة
الثاني: الحفاظ على حياته (صلوات الله عليه) وحياة الثلّة الصالحة من شيعته، ممّنْ آمن بالإسلام الحقّ بإخلاص وتفهم، واستعداد للتضحية من أجل أن يحمل هو (عليه السّلام) وهذه الثلّة الإسلام الحقّ من دون تحريف وتشويه؛ ليتسنّى لهم - في الوقت المناسب - تعريف عامّة المسلمين به؛ سواء مَنْ كان منهم مسلماً عند انتقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرفيق الأعلى، أم مَنْ يدخل بعد ذلك في الإسلام، ثمّ تهيئة ثلّة تحمل دعوة الإسلام الحقّ؛ لتبشّر به وتهيئ الحَمَلة له، وهكذا ما بقيت الدنيا.
لتبقى هذه الدعوة مسموعة في الأرض، ولا يُقضى عليها بالقضاء على حملتها في مبدأ الانحراف والانشقاق؛ كي لا ينفرد الإسلام المشوّه بالساحة، وقد تعرّضنا لذلك بشيء من التوضيح في خاتمة كتابنا (أصول العقيدة ).
وبذلك يظهر أنّه لا مجال لقيام أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) بتضحية شبيهة بتضحية الإمام الحسين (عليه السّلام).
الصراع الحاد بين الصدر الأوّل يعرّض الكيان الإسلامي للانهيار
أوّلاً : لأنّ الصراع الحاد بعد ارتحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرفيق الأعلى يعرّض الكيان الإسلامي العام للوهن والتفكّك، أو الانهيار بردّة ونحوه؛ لأنّ الناس حديثو عهد بالإسلام، ولم يتركز بَعْدُ في نفوسهم.
قال أنس بن مالك: وما نفضنا أيدينا من تراب قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنكرنا قلوبنا(١) .
وقال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في خطبة له عند مسيره إلى البصرة: «إنّ الله لما قبض نبيّه استأثرت علينا قريش بالأمر، ودفعتنا عن حق نحن أحق به من الناس كافة؛ فرأيت أنّ الصبر على ذلك أفضل من تفريق كلمة المسلمين وسفك دمائهم، والناس حديثو عهد بالإسلام، والدين يمخض مخض الوطب، يفسده أدنى وهن، ويعكسه أقلّ خلف...»(٢) .
وقد تكرّر من أمير المؤمنين وبقية الأئمّة (صلوات الله عليهم) بيان هذه المضامين ونحوها.
قوّة الكيان الإسلامي العام في عصر الإمام الحسين (عليه السّلام)
ولا يُقاس ذلك بعصر الإمام الحسين (صلوات الله عليه)؛ حيث ضرب
____________________
١ - مسند أبي يعلى ٦/١١٠ فيما رواه عاصم عن أنس، واللفظ له، مسند أحمد ٣/٢٢١، ٢٦٨ مسند أنس، سنن ابن ماجة ١/٥٢٢ كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وآله وسلم، سنن الترمذي ٥/٢٤٩ أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في باب لم يسمه قبل باب ما جاء في ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صحيح ابن حبان ١٤/٦٠١ كتاب التاريخ، باب وفاته (صلّى الله عليه وسلم)، ذكر إنكار الصحابة قلوبهم عند دفن صفي الله صلى الله عليه وآله وسلم، الاستذكار - لابن عبد البر ٣/٨٠، التمهيد - لابن عبد البر ١٩/٣٢٣، وج ٢٣/٣٩٤، تفسير القرطبي ٤/٢٢٥، وغيرها من المصادر الكثيرة جدّاً.
٢ - شرح نهج البلاغة ١/٣٠٨.
الإسلام بجرانه، وانتشر في الأرض، وعمّت دعوته، وتركّز في النفوس؛ نتيجة المكاسب المادية والمعنوية التي حقّقها لأتباعه، ويأتي في كلام أمير المؤمنين (عليه السّلام) ما يناسب ذلك.
كما إنّ قيام دولة قاهرة واسعة الرقعة باسم الإسلام من أهم العوامل الحافظة لدعوته؛ لاهتمام ذوي المطامع في السلطة والنفوذ بالحفاظ على هذه الدعوة من أجل استغلالها لنيل مطامعهم.
الصراع الحاد يعرّض الخاصة للخطر
وثانياً: لأنّ الصراع الحاد يعرّض أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) والثلّة الصالحة الثابتة على الحقّ من أصحابه للخطر.
وبالقضاء عليهم لا يبقى ناطق بدعوة الحقّ يُسمعها للناس بعد انتشار الإسلام في الأرض، وينفرد الإسلام الحاكم في الساحة من دون معارضة تقف في وجهه، وتحدّ من نشاطه في التثقيف والتحريف.
مع إنّه لا أثر للتضحية من أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) وخاصة أصحابه؛ لعدم تركز مفاهيم الإسلام، وعدم ظهور مقام أهل البيت (صلوات الله عليهم) ولا ظلامتهم بعد، بل لا يخرج الصراع بنظر عموم الناس عن كونه صراعاً على السلطة، غلب فيه مَنْ غلب، وخسر مَنْ خسر.
تركّز دعوة التشيّع في عصر الإمام الحسين (عليه السّلام)
وهذا بخلاف عصر الإمام الحسين (صلوات الله عليه)؛ لظهور مقام أهل البيت (صلوات الله عليهم) ورفعة شأنهم، ووضوح ظلامتهم؛ نتيجة الجهود المكثّفة السابقة.
كما تجلّت في هذه المدّة معالم دعوة التشيّع وتركّزت، وحصلت على أُمّة كبيرة تتفهّمه، وترجع في دينها لبقية الأئمّة من أهل البيت (صلوات الله عليهم)، بل سبق أنّ فاجعة الطفّ قد رفعت من شأن هذه الدعوة الشريفة، وصارت سبباً في قوّتها وفاعليتها وانتشارها، وتعاطف الناس معها، بل هي نقطة تحوّل فيها.
حاول أمير المؤمنين (عليه السّلام) تعديل مسار السلطة لكنّه فقد الناصر
نعم، حاول أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) أن ينهض في وجه الانحراف، لا من أجل محض التضحية كما فعل الإمام الحسين (عليه السّلام)، بل من أجل تعديل مسيرة الإسلام في أوّل الأمر على أن يكسب لجانبه جماعة صالحة تكون ركيزة لدعوة الحقّ، ويقوم بها كيان الإسلام، ترهب المنحرفين أو ترغمهم، فيفيئوا إليه، ويرجعوا للطريق المستقيم.
لكنّه (عليه السّلام) لم يجد من الأنصار ما يكفي لذلك كما تضمّنه تراث المسلمين، وذكرنا طرفاً منه في جواب السؤال الثالث من الجزء الثاني من كتابنا (في رحاب العقيدة).
فاضطر للسكوت والصبر، والحفاظ على نفسه الشريفة، وعلى الثلّة الصالحة ممّنْ ثبت معه أو رجع إليه بعد ذلك، بانتظار الفرصة المناسبة؛ ليؤدّوا دورهم في كبح جماح الانحراف، بإظهار دعوة الحقّ، وتنبيه الأُمّة من غفلتها.
دعوى أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) فرّط ولم يستبق الأحداث
هذا وقد يُقال: إنّ الانحراف إنّما حصل لأنّ أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) لم يستعمل الحزم، ولم يستبق الأحداث، وانشغل بتجهيز النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى
تمّ للآخرين ما أرادوا.
وهو (عليه السّلام) وإن حافظ بذلك على مبدئيته ومثاليته بنحو يدعو للإعجاب والإكبار:
أوّلاً : في احترام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال (صلوات الله عليه): «أفكنت أدع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته لم أدفنه، وأخرج أنازع الناس سلطانه؟!»(١) .
وثانياً : في نظرته للخلافة والسلطة حيث لم يجعلها مغنماً يتسابق إليه، بل هي حق يجب على المسلمين تسليمه له (عليه السّلام)، ويحرم عليهم منازعته فيها.
إلاّ إنّه (صلوات الله عليه) فرّط بذلك في حق الإسلام حيث فسح للمنحرفين المجال للتحكم فيه بنحو لا يمكن تداركه، وتجنّب ذلك أهم من الحفاظ على المثالية من الجهتين المتقدّمتين.
الجواب عن الدعوى المذكورة
والجواب عن ذلك: إنّه قد ورد بطرق مختلفة أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد عهد إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في هذا الأمر، فلم يتجاوز عهده.
وعنه (صلوات الله عليه) أنّه قال: «قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن اجتمعوا عليك فاصنع ما أمرتك، وإلاّ فألصق كلكلك بالأرض. فلمّا تفرّقوا عنّي جررت على المكروه ذيلي، وأغضيت على القذى جفني، وألصقت بالأرض كلكلي»(٢) . وفي كلام للفضل بن العباس: وإنّا لنعلم أنّ عند صاحبنا عهداً هو ينتهي إليه(٣) ... إلى غير ذلك(٤) .
____________________
١ - الإمامة والسياسة ١/١٦ إباية علي (كرم الله وجهه) بيعة أبي بكر (رضي الله عنه).
٢ - شرح نهج البلاغة ٢٠/٣٢٦.
٣ - شرح نهج البلاغة ٦/٢١، الموفقيات/٥٨٠ ح ٣٨٠.
٤ - راجع الأمالي - للمفيد/٢٢٣ - ٢٢٤، والأمالي - للطوسي/٩، وخصائص الأئمّة/٧٢ - ٧٥، =
ولعلّ الوجه في ذلك أحد أمرين، أو كلاهما:
الأوّل : إنّ دعوة الإسلام الرفيعة في بدء ظهورها لم تتركّز ولم تأخذ موقعها المناسب في النفوس كعقيدة مقدّسة، فإذا ظهر من أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) - الذي هو يمثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موقعه - الاهتمام بالسلطة والمغالبة عليه، وترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم جثّة لم يجهّز من أجل تحصيله كان ذلك وهناً على هذه الدعوة الشريفة يزعزع جانب القدسية والمبدئية فيه، ويضعف موقعها العقائدي في النفوس، وذلك من أعظم المخاطر عليه.
الثاني : إنّ الله (عزّ وجلّ) يعلم أنّ الأمر لا يتمّ له (عليه السّلام) لو سابَق الأحداث، وسارع بأخذ البيعة ممّنْ يستجيب له؛ لإصرار الحزب القرشي على صرف الخلافة عن أهل البيت عموماً، وعن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) خصوصاً، إصراراً لا يقف عند حدّ دون تحقيق مشروعهم، ولفقد أمير المؤمنين (عليه السّلام) العدد الكافي من الأنصار من ذوي الثبات والإصرار على الحقّ؛ ليتسنّى له الوقوف أمام إصرارهم.
فتمسّكه (صلوات الله عليه) بحقّه، وسَبقه إليه بأخذ البيعة ممّنْ هو مقتنع به يستلزم نفس المحذور الذي يلزم من إصراره (صلوات الله عليه) على استرجاع حقه بعد أن سبقوه له، وهو انشقاق المهاجرين والأنصار على أنفسهم، الموجب لوهن كيان الإسلام في بدء قيامه بنحو قد يؤدّي إلى الردّة العامّة أو نحوها؛ لعدم استحكام الدين في النفوس.
والبقيّة الصالحة التي تثبت على الدين لو سَلِمت بعد الانشقاق والصراع فهي من القلّة والضعف بحيث لا تقوى على تشييد كيان الإسلام الحقّ،
____________________
= والاحتجاج ١/٢٨٠ - ٢٨١، ٢٩١، وكشف الغمة ٢/٤، وبحار الأنوار ٢٩/٥٨٢، وغيرها من المصادر.
والحفاظ عليه، ثمّ حمله للأجيال، وتبليغهم به.
بل قد يُقضى على أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) وعلى البقية الصالحة من الصحابة؛ نتيجة الصراع والإصرار المذكورين، فتضيع معالم الحقّ، ولا يبقى مَنْ يبلغ الأجيال بالدعوة على صفائها ونقائها، وينفرد المنحرفون أو المرتدّون بالساحة.
أمّا تراجع أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) عن الخلافة بعد أن يبايَع، وتسليمها لجماعة الحزب القرشي إذا رأى منهم الإصرار؛ تجنّباً لمخاطر الصراع، فهو أوهن عليه، وأضعف لموقفه من التريّث في الأمر حتى يسابقوه كما حصل، ولاسيما أنّه قد يضفي شرعية على إصرارهم واسترجاعهم للسلطة.
على أنّ ذلك قد يزيد في مخاوفهم من أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)، فيقضون عليه كما قُضي أخيراً على مرشّح الأنصار سعد بن عبادة.
وقد ورد أنّهم قد حاولوا قتله (عليه السّلام) مع إنّه لم يسابقهم، بل لمجرّد كونه صاحب الحقّ شرعاً، وقد تلكأ في بيعة أبي بكر كما تعرّضنا لذلك في خاتمة كتابنا (أصول العقيدة)، فكيف يكون الحال لو سابقهم واستولى على الخلافة، ثمّ استرجعت منه قسراً عليه؟!
حديث لأمير المؤمنين (عليه السّلام) في تقييم الأوضاع
ويناسب ذلك ما ورد عن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)، فقد قال له قائل: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك ولداً ذكراً قد بلغ مبلغ الحلم، وأنس منه الرشد، أكانت العرب تسلّم إليه أمرها؟ قال (عليه السّلام): «لا، بل كانت تقتله إن لم يفعل ما فعلت؛ إنّ العرب كرهت أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحسدته على ما آتاه الله من فضله، واستطالت أيامه حتى قذفت زوجته، ونفّرت به ناقته،
مع عظيم إحسانه إليها، وجسيم مننه عندها، وأجمعت منذ كان حياً على صرف الأمر عن أهل بيته بعد موته.
ولولا أنّ قريشاً جعلت اسمه ذريعة إلى الرئاسة، وسلماً إلى العزّ والإمرة، لما عبدت الله بعد موته يوماً واحداً، ولارتدّت في حافرتها، وعاد قارحها جذعاً، وبازلها بكراً.
ثمّ فتح الله عليها الفتوح؛ فأثرت بعد الفاقة، وتموّلت بعد الجهد والمخمصة، فحسن في عيونها من الإسلام ما كان سمجاً...»(١) إلى آخر ما تقدّم عنه (عليه السّلام) في أوائل الفصل الأوّل من المقصد الثاني.
والحاصل: إنّ ملاحظة وضع المسلمين عند ارتحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرفيق الأعلى، وما تتابع من أحداث مأساوية يشهد بوهنهم وضعفهم عن الحفاظ على استقامة مسيرة الإسلام أمام ضغط الحزب القرشي ومؤامراته؛ إمّا خوفاً منه، أو لعدم تركّز الدين في نفوسهم بحيث ابتلوا بالتواكل والتخاذل واللامبالاة، ولله أمر هو بالغه.
فكان أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) مضطراً للتعامل معهم بالوجه الذي حصل، والاكتفاء بالحفاظ على ما يمكن أن يكبح به جماح الانحراف في الوقت المناسب في صراع مرير طويل قدّره الله سبحانه وتعالى لهذه الأُمّة.
والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وله الأمر من قبل ومن بعد، وإليه يرجع الأمر كلّه.
____________________
١ - شرح نهج البلاغة ٢٠/٢٩٨ - ٢٩٩. وتقدم تتمة كلامه عليه السلام في ص: ١٦٧.
الفصل الثاني
في موقف الإمام الحسن (عليه السّلام)
إذا كان الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مهبّ الرياح؛ لعدم استحكامه في نفوس كثير من معتنقيه، لقرب عهدهم بالجاهلية بحيث يخشى من أن يؤدّي ظهور الخلاف والشقاق بين المسلمين إلى انهيار الكيان الإسلامي بردّة ونحوها - كما سبق -، فلا مجال لذلك في عهد الإمام الحسن (صلوات الله عليه)؛ حيث قد ضرب الإسلام بجرانه، واتسعت رقعته، وتعاقبت الأجيال عليه، وتدفّقت الخيرات على المسلمين بسبب الفتوح الكبرى، فهم بين مَنْ يتمسّك به ويدعو له كعقيدة راسخة - عن بصيرة كاملة، أو عن تأثّر بالمجتمع -، ومَنْ يتمسّك به ويدعو له لمصالحه الشخصية من مال أو جاه، أو نفوذ أو سلطان.
ومن ثمّ فالظاهر أنّ موقف الإمام الحسن (صلوات الله عليه) لم يكن ناشئاً من الحذر على كيان الإسلام العام، كما كان هو الحال في موقف أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسّلام) بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرفيق الأعلى.
ولا بدّ أن يستند موقف الإمام الحسن (عليه السّلام) لوجوه أُخر يحسن بنا التعرّض لما يتيسّر لنا إدراكه منه.
والكلام.. تارة: في صلحه (صلوات الله عليه) مع معاوية.
وأُخرى : في صبره وعدم تغييره بعد ظهور الغدر من معاوية، ونقضه للعهد، وانتهاك الحرمات العظام؛ فالكلام في مقامين:
المقام الأوّل
في صلح الإمام الحسن (عليه السّلام) مع معاوية
قد كثر الحديث في الصلح المذكور تقييماً ونقداً حسب اختلاف توجّهات المتحدّثين ومداركهم، ولا يسعنا تعقيب ما ذكروه، بل الأنسب الاقتصار على عرض وجهة نظرنا وتقريبه، فنقول:
تعذّر انتصار الإمام الحسن (عليه السّلام) عسكرياً
الذي يتراءى لنا أنّ إصرار الإمام الحسن (صلوات الله عليه) على حرب معاوية وثباته عليها حتى النهاية إن كان من أجل الانتصار، والحفاظ على استقامة مسار السلطة في الإسلام، فالنظرة الموضوعية لظروف الصراع بين الإمام ومعاوية تشهد بتعذّر انتصار الإمام (عليه السّلام) عسكرياً.
وذلك لتصاعد قوّة معاوية وطغيانه، ووهن أهل العراق بعد التحكيم الذي أشعرهم بالخيبة، وسبّب لكثير منهم الإحباط.
ولاسيما بعد انشقاقهم على أنفسهم في فتنة الخوارج وحربهم معهم، وما تسبب عن ذلك أو قارنه من ظهور الأحقاد بينهم، ومللهم من الحرب، وضعف بصائر كثير منهم، وانفتاح عيون جماعة من رؤسائهم على الدنيا، وانخداعهم بالمغريات التي كانوا ينتظرونها من معاوية، ولا يتوقّعون شيئاً منها من الإمام الحسن (عليه السّلام)؛ نتيجة مبدئيته وسيره على نهج أبيه (صلوات الله عليه)... إلى
غير ذلك.
وإذا كان في معسكر الإمام (صلوات الله عليه) جماعة - من ذوي البصائر والإصرار على المضي في الحرب - قد ظهر منهم التبرّم من موقف الإمام (عليه السّلام) كما يأتي من بعضهم، فذلك منهم ناشئ عن قوّة بصيرتهم في حقّهم وفي باطل معاوية، وشدّة إبائهم للضيم بحيث فقدوا النظرة الموضوعية لواقع القوّتين المتصارعتين، والموازنة بينهم، وملاحظة نتائج الحرب وتأثيرها على الدعوة الحقّة على الأمد القريب والبعيد.
خطبة الإمام الحسن (عليه السّلام)
وقد أوضح ذلك الإمام الحسن (صلوات الله عليه) في خطبته لأصحابه التي رواها ابن الأثير بسنده عن ابن دريد، وفيها: «إنّا والله ما ثنانا عن أهل الشام شك ولا ندم، وإنّا كنّا نقاتل أهل الشام بالسلامة والصبر، فسُلبت السلامة بالعداوة، والصبر بالجزع، وكنتم في منتدبكم إلى صفين ودينكم أمام دنياكم، فأصبحتم اليوم ودنياكم أمام دينكم. ألا وإنّا لكم كما كنّا، ولستم لنا كما كنتم. ألا وقد أصبحتم بين قتيلين: قتيل بصفين تبكون له، وقتيل بالنهروان تطلبون ثاره. فأمّا الباقي فخاذل وأمّا الباكي فثائر. ألا وإنّ معاوية دعانا إلى أمر ليس فيه عزّ ولا نصفة، فإن أردتم الموت رددناه عليه، وحاكمناه إلى الله (عزّ وجلّ) بظبا السيوف، وإن أردتم الحياة قبلناه، وأخذنا لكم الرضا». قال: فناداه القوم من كلّ جانب: البقيّة البقيّة. فلمّا أفردوه أمضى الصلح(١) .
____________________
١ - أسد الغابة ٢/١٣ في ترجمة الحسن بن علي بن أبي طالب، واللفظ له، سير أعلام النبلاء ٣/٢٦٩ في ترجمة الحسن بن علي بن أبي طالب، الكامل في التاريخ ٣/٤٠٦ أحداث سنة إحدى وأربعين من الهجرة، ذكر تسليم الحسن بن علي الخلافة إلى معاوية، وغيرها من المصادر.
وقد روى هذه الخطبة الديلمي بتغيير يسير، وفيه: «فأمّا الباكي فخاذل، وأمّا الطالب فثائر»(١) .
وفي كتاب له عليه السلام إلى معاوية: «أما بعد فإن خطبي انتهى إلى اليأس من حث أحييه وباطل أميته، وخطبك خطب من انتهى إلى مراده. وإنني أعتزل هذا الأمر وأخليه لك. وإن كان تخليتي إياه شراً لك في معادك. ولي شروط أشرطها...»(٢) . ويأتي منه (عليه السّلام) كلام آخر يناسب ذلك، ونحوهما غيرهما وإن كان الأمر أظهر من ذلك.
مخاطر الانكسار العسكري على دعوة الحقّ وحملتها
وحينئذ فخروج الإمام الحسن (صلوات الله عليه) من الصراع بصلح يبتني على الشروط والعهد والميثاق، خير من خروجه بانكسار عسكري ينفرد به معاوية بالقرار. لوجوه:
الأوّل : إنّ الانكسار العسكري لا يحصل إلّا بعد أن تأكل الحرب ذوي البصائر الذين هم حصيلة جهود أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)، لقوّة إصرارهم وتصميمهم على التضحية.
مع إنّ دعوة التشيّع في أمسّ الحاجة لهم من أجل حملها والتبليغ بها والدعوة له؛ لأنّها كانت حديثة الظهور على الصعيد العام في المجتمع الإسلامي، وكان حاميها القوّة بسبب تسنّم أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) للسلطة من دون أن تتركّز عقائدياً على الصعيد العام، ولم تأخذ موقعها المناسب في المسلمين، فتبقى مهزوزة في مهبّ الرياح بعد انحسار سلطان أهل البيت (صلوات الله
____________________
١ - أعلام الدين/٢٩٢ - ٢٩٣.
٢- علل الشرائع ج: ١ ص: ٢٢١ باب: ١٦٠.
عليهم).
وحينئذ يسهل على معاوية اكتساحها بعد انتصاره وقوّة سلطانه كما حاول ذلك وبذل غاية جهده، وإن لم يفلح نتيجة جهود هذه الجماعة، ووقوفها أمام مشروعه المذكور.
وهذا بخلاف الحال عند نهضة الإمام الحسين (صلوات الله عليه)؛ حيث قد تركّزت الدعوة عقائدياً، وتجذّرت في المجتمع الإسلامي، فالتضحية به (عليه السّلام) وبالنخبة الصالحة معه لم تؤثّر على سير الدعوة، بل كانت نقطة تحوّل فيه زادتها عزّةً وبهاءً، وقوّةً ورسوخاً، وظهوراً وانتشاراً، كما سبق.
ومعاوية وإن كان قد نقض العهد، وتتبّع كثيراً من الشيعة بعد ذلك قتلاً وسجناً وتشريداً وتنكيلاً، إلّا إنّ ذلك لا يبلغ محذور القضاء عليهم واستئصالهم في الحرب، أو بعد أن يتمّ له الانتصار:
أوّلاً : لأنّ معاوية لم يقضِ عليهم كلّهم، بل بقي كثير منهم، وقد بذلوا جهودهم لصالح دعوة الحقّ في حياة معاوية وبعد موته.
وثانياً : لأنّه لم يقضِ على كثير ممّنْ قضى عليهم إلّا بعد فترة استطاع فيها الضحية أن يؤدّي وظيفته في التبليغ بالدعوة الشريفة وتوضيح معالمها، وطبع بصماتها في المجتمع، وكان لذلك أثره الحميد في بقاء دعوة التشيّع، وتوارث الأجيال لها، واتساع رقعتها.
وثالثاً : لأنّ ظلامات الضحايا، ومواقفهم الصلبة في سبيل مبادئهم صارت وسام شرف للتشيّع؛ حيث اصطبغ بالدماء، وصار عنواناً لمقارعة الباطل، والصرخة في وجوه الظالمين، والتضحية من أجل المبادئ الحقّة، وقد تحقّق ذلك لأوّل مرّة في داخل المجتمع الإسلامي.
نظير موقف المسلمين المستضعفين الذين تعرّضوا للأذى والتعذيب من
المشركين في مبدأ ظهور الإسلام، مع فارق الكمّ والكيف.
كما صارت تلك الظلامات سمة عارٍ على الحكم الأموي، وأحد الأسباب المهمّة في تشويه صورته، وزعزعة شرعيته، ولاسيّما إنّه يذكّر بموقف الأمويين السيئ من الإسلام في مبدأ ظهوره، وإنّ القوم أبناء القوم.
وخصوصاً إنّ ذلك ابتنى على نقض العهد والاستهانة به؛ استهتاراً بالمبادئ والقيم، وقد صرّح معاوية بذلك من أوّل الأمر؛ فقد قال في خطبته بالنخيلة عند دخوله الكوفة: ألا إنّ كلّ شيء أعطيته الحسن بن علي تحت قدمي هاتين لا أفي به(١) .
مع إنّ كثيراً من أولئك الضحايا لهم أثرهم المحمود في الإسلام، ومكانتهم السامية في نفوس المسلمين، وقد هزّ مقتل حجر بن عدي وأصحابه المجتمع الإسلامي، وهو أحد أحداث معاوية وموبقاته المذكورة، فكيف صارت نظرة المسلمين لمعاوية بسبب ما سبقه ولحقه من جرائمه وتعدياته الكثيرة؟!
الثاني : إنّ قتل مَنْ يُقتل من الشيعة في الحرب أمر تقتضيه طبيعة الحرب، لا يُعَدّ بنظر جمهور الناس جريمة من معاوية، بل حتى قتلهم بعد حصول الانكسار العسكري؛ لأنّ المحاربين يكونون أسرى لا يستنكر من المنتصر قتلهم في تلك العصور.
ولذا عدّ عفو النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المشركين بعد فتح مكة، وعفو أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) عن المقاتلين بعد حرب الجمل، تفضّلاً منهما.
أمّا قتل الإمام الحسن (صلوات الله عليه) وأهل بيته وشيعته بعد الموادعة وأخذ العهود والمواثيق فهو من أعظم الجرائم الإنسانية والمستنكرات بنظر
____________________
١ - مقاتل الطالبيين/٤٥ في ترجمة الحسن بن علي بن أبي طالب (عليه السّلام)، واللفظ له، شرح نهج البلاغة ١٦/٤٦، أنساب الأشراف ٣/٢٩١ أمر الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهما السّلام).
الخاصة والعامة.
وبذلك استطاع الإمام الحسن (عليه السّلام) أن يعصم دمه الزكي ودماء أهل بيته وشيعته، ويحفظ لهم حرمتهم، ويجعل قتل مَنْ قُتل منهم، والاعتداء على الباقين بوجوه أُخر جرائم مستنكرة دينياً وإنسانياً تشوّه صورة الحكم الأموي، وسبباً للتشنيع عليه والتنفير منه، وهو من أهم المكاسب في الصراع المبدئي.
الثالث: إنّ معاوية ليس كيزيد في الطيش والعنجهية، بل يختلف عنه بالحنكة وبُعْد النظر. والظاهر أنّ ذلك يمنعه من قتل الإمام الحسن (صلوات الله عليه) وأهل بيته لو لم يُقتلوا في المعركة؛ لما لهم من المقام الديني الرفيع، والمكانة السامية في نفوس المسلمين، فلا يثير على نفسه غضب المسلمين بقتلهم، بل يستبقيهم؛ ليظهر بمظهر الحليم المتفضّل بعفوه بعد المقدرة.
وفي ذلك أعظم الوهن عليهم، وعلى دعوتهم الشريفة، كما يكون حاجزاً لهم عن الإنكار عليه في ممارساته الإجرامية ضدّ الدين والمسلمين؛ حيث يكون بنظر عامّة الناس من الردّ على الإحسان بالإساءة.
ولا أقلّ من أن يستغل معاوية ذلك ضدّهم ويوظّف قدراته التثقيفية والإعلامية للتهريج عليهم به، وتشويه صورتهم؛ من أجل أن يستغفل الناس، ويشغلهم به عن التوجّه لجرائمه ونقده.
تصريحات الإمام الحسن وبقيّة الأئمّة (عليهم السّلام) في توجيه الصلح
وقد أشار الإمام الحسن (صلوات الله عليه) وبقيّة الأئمّة (عليهم السّلام) لكثير ممّا ذكرنا من أجل توجيه موقفه مع معاوية، وإقدامه على صلحه ومهادنته، وإقناع خواص أصحابه، والتخفيف من غلواء انفعالهم من الحدث المذكور، وأسفهم له.
ففي حديث له (عليه السّلام) عن صلحه مع معاوية: «والله، ما سلّمت الأمر إليه إلّا إنّي لم أجد أنصاراً، ولو وجدت أنصاراً لقاتلته ليلي ونهاري حتى يحكم الله بيني وبينه، ولكنّي عرفت أهل الكوفة وبلوتهم، ولا يصلح لي منهم مَنْ كان فاسداً؛ إنّهم لا وفاء لهم ولا ذمّة في قول ولا فعل، إنّهم لمختلفون، ويقولون لنا إنّ قلوبهم معنا، وإنّ سيوفهم لمشهورة علينا»(١) .
وفي حديث له (سلام الله عليه) طويل مع أبي سعيد عقيصا قال: «يا أبا سعيد، إذا كنت ممّا مَنْ قبل الله تعالى ذكره لم يجب أن يسفّه رأيي فيما أتيته من مهادنة أو محاربة وإن كان وجه الحكمة فيما أتيته ملتبس. ألا ترى الخضر لما خرق السفينة، وقتل الغلام، وأقام الجدار سخط موسى (عليه السّلام) فعله؛ لاشتباه وجه الحكمة عليه حتى أخبره فرضي. هكذا أنا سخطتم عليّ بجهلكم بوجه الحكمة فيه، ولولا ما أتيت لما تُرك من شيعتنا على وجه الأرض أحد إلّا قُتل»(٢) .
وفي رواية أُخرى عنه (عليه السّلام) أنّه قال: «إنّما هادنت حقناً للدماء وصيانته، وإشفاقاً على نفسي وأهلي والمخلصين من أصحابي»(٣) .
وقال (عليه السّلام) لحجر بن عدي: «يا حجر، إنّي قد سمعت كلامك في مجلس معاوية، وليس كلّ إنسان يحبّ ما تحبّ، ولا رأيه كرأيك، وإنّي لم أفعل ما فعلت إلّا إبقاء عليكم، والله تعالى كلّ يوم هو في شأن»(٤) .
وفي حديث له (عليه السّلام) آخر معه قال: «إنّي رأيت هوى عظم الناس في الصلح
____________________
١ - الاحتجاج ٢/١٢، بحار الأنوار ٤٤/١٤٧.
٢ - بحار الأنوار ٤٤/٢، علل الشرائع ١/٢١١، الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف/١٩٦.
٣ - مناقب آل أبي طالب - لابن شهرآشوب ٣/١٩٦، تنزيه الأنبياء/٢٢٢، بحار الأنوار ٤٤/٥٦.
٤ - الفتوح - لابن أعثم ٤/٢٩٥ ذكر مسير معاوية إلى العراق لأخذ البيعة لنفسه من الحسن بن علي، واللفظ له، مناقب آل أبي طالب - لابن شهرآشوب ٣/١٩٧، بحار الأنوار ٤٤/٥٧، شرح نهج البلاغة ١٦/١٥.
وكرهوا الحرب، فلم أحبّ أن أحملهم على ما يكرهون، فصالحت بقياً على شيعتنا خاصة من القتل، ورأيت دفع هذه الحروب إلى يوم ما؛ فإن الله كلّ يوم هو في شأن»(١) .
وفي حديث ثقيف البكّاء قال: رأيت الحسن بن علي (عليه السّلام) عند منصرفه من معاوية وقد دخل عليه حجر بن عدي، فقال: السّلام عليك يا مذلّ المؤمنين.
فقال: «مه؛ ما كنت مذلّهم، بل أنا معزّ المؤمنين، وإنّما أردت البقاء عليهم...»(٢) .
وقال (صلوات الله عليه) لعلي بن محمد بن بشير الهمداني: «ما أردت بمصالحتي معاوية إلّا أن أدفع عنكم القتل عندما رأيت من تباطؤ أصحابي عن الحرب، ونكولهم عن القتال. والله، لئن سرنا إليه بالجبال والشجر ما كان بد من إفضاء هذا الأمر إليه»(٣) .
وقال فضيل بن مرزوق: أتى مالك بن ضمرة الحسن بن علي، فقال: السّلام عليك يا مسخم وجوه المؤمنين.
قال: «يا مالك لا تقل ذلك؛ إنّي لما رأيت الناس تركوا ذلك إلّا أهله خشيت أن تُجتثّوا عن وجه الأرض، فأردت أن يكون في الأرض ناعياً».
فقال: بأبي وأُمّي ذرية بعضها من بعض(٤) .
وفي حديث له (صلوات الله عليه) مع زيد بن وهب الجهني عن أصحابه لما طُعن (عليه السّلام) بالمدائن قال: «أرى والله أنّ معاوية خير لي من هؤلاء؛ يزعمون أنّهم لي شيعة، ابتغوا قتلي، وانتهبوا ثقلي، وأخذوا مالي. والله لئن آخذ من معاوية عهداً أحقن به دمي، وأومن به في أهلي خير من أن يقتلوني فيضيع أهل بيتي وأهلي. والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سلماً. والله لئن
____________________
١ - الأخبار الطوال/٢٢٠ عند ذكر زياد بن أبيه.
٢ - دلائل الإمامة/١٦٦.
٣ - الأخبار الطوال/٢٢١ عند ذكر زياد بن أبيه.
٤ - تاريخ دمشق ١٣/٢٨٠ في ترجمة الحسن بن علي بن أبي طالب.
أُسالمه وأنا عزيز خير من أن يقتلني وأنا أسير، أو يمنّ عليّ فتكون سبة على بني هاشم إلى آخر الدهر، ومعاوية لا يزال يمنّ بها وعقبه على الحي منّا والميت»(١) .
وفي حديث له (عليه السّلام) لما دخل عليه الناس فلامه بعضهم على بيعته قال (عليه السّلام): «ويحكم! ما تدرون ما عملت. والله الذي عملت خير لشيعتي ممّا طلعت عليه الشمس أو غربت. ألا تعلمون أنّني إمامكم مفترض الطاعة عليكم، وأحد سيّدي شباب أهل الجنّة بنصّ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليّ؟!». قالوا: بلى. قال: «أما علمتم أنّ الخضر (عليه السّلام) لما خرق السفينة...»(٢) .
وفي حديث للإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر (صلوات الله عليه): «والله، للذي صنعه الحسن بن علي (عليهما السّلام) كان خيراً لهذه الأُمّة ممّا طلعت عليه الشمس»(٣) . وفي حديث آخر له عليه السلام عن سدير وفيه: «إن العلم الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند علي عليه السلام. من عرفه كان مؤمناً، ومن جحده كان كافراً. ثم كان بعده الحسن عليه السلام. قلت: كيف يكون بذلك المنزلة وقد كان منه ما كان. دفعها إلى معاوية؟ فقال: اسكت، فإنه أعلم بما صنع. لولا ما صنع لكان أمر عظيم»(٤) ... إلى غير ذلك ممّا ورد عن الإمام الحسن وعن بقيّة الأئمّة (صلوات الله عليهم أجمعين).
والحاصل: إنّ الإمام الحسن (صلوات الله عليه) قد نقل الشيعة بصلحه هذا من مقاتلين في حرب فاشلة، لا حرمة لهم في أعراف الحرب - خصوصاً في ذلك العصر - إلى معارضة يعتصمون بالعهد، ويتمتعون بكافة حقوق المسلمين،
____________________
١ - الاحتجاج ٢/١٠، بحار الأنوار ٤٤/٢٠.
٢ - كمال الدين وتمام النعمة/٣١٦، الاحتجاج ٢/٩، بحار الأنوار ٥١/١٣٢، إعلام الورى بأعلام الهدى ٢/٢٣٠.
٣ - الكافي ٨/٣٣٠، بحار الأنوار ٤٤/٢٥، تفسير العياشي ١/٢٥٨.
٤ - علل الشرائع ج: ١ ص: ٢١٠ - ٢١١ باب: ١٥٩.
ولهم حرمة الدم والمال.
وبذلك يكون من حقّهم أن يقوموا بنشاطهم في خدمة خطّ أهل البيت (صلوات الله عليهم)، وهو ما حصل فعلاً؛ فقد بذلوا في سبيل ذلك جهوداً مكثفة أدّت إلى ظهور الدعوة الحقّة، وانتشارها على الصعيد العام بين المسلمين.
ولاسيما بعد أن تفرّغ الإمام الحسن (صلوات الله عليه) ومَنْ معه من بني هاشم بعد الصلح للجانب الثقافي، وواصلوا الشوط الذي بدأه أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسّلام) وأكّدوا المفاهيم التي طرحها بين المسلمين.
غاية الأمر أنّ معاوية بعدوانه وغشمه لم يمتع الشيعة بالحقوق المذكورة كاملة، ونكل بهم بعد ذلك، وحاول القضاء عليهم وتطويق الدعوة لخطّ أهل البيت (عليهم السّلام).
لكنّ ذلك - في واقعه - زاد من قوّة خطّ أهل البيت (صلوات الله عليهم)، وصار سبباً في بلورة دعوتهم وظهوره، وتركزها وانتشارها بين المسلمين.
لا مجال لاستمرار الإمام (عليه السّلام) في الحرب حتى النفس الأخير
ومن جميع ما ذكرنا ظهر أنّه لا مجال لقول مَنْ يقول: كان على الإمام الحسن (صلوات الله عليه) الاستمرار في الحرب، لا من أجل الانتصار العسكري؛ لما سبق من تعذّره، بل كان عليه أن يستمر في الحرب حتى النفس الأخير وإن ضحى بنفسه وأهل بيته كما فعل الإمام الحسين (صلوات الله عليه).
إذ نقول في جواب ذلك: إنّ تضحية الإمام الحسين (عليه السّلام) لم تكن لمجرد الإباء والامتناع عن الخضوع للظالم ترفّعاً وإنكاراً للمنكر؛ ليشترك الإمام الحسن (عليه السّلام) معه في ذلك، وإنّما كان من أجل صلاح الدين على الأمد البعيد. ولا يتحقق ذلك في حق الإمام الحسن (عليه السّلام)؛ لاختلاف ظروفه (عليه السّلام) عن ظروف نهضة
الإمام الحسين (عليه السّلام):
أوّلاً : لأنّ معاوية قد استولى على الخلافة بعد حرب طاحنة، برّرها بالطلب بدم عثمان، ثمّ استتبعت التحكيم الذي أضفى على خلافته شرعية صورية.
كما إنّ استمراره في الصراع بقوّة عسكرية آخذة بالتزايد جعلت منه واقعاً مفروضاً لا يُقهر، ويجب التعامل معه بحكمة بنظر جمهور الناس، وكثير من خاصتهم.
وليس هو كيزيد الذي استولى على الخلافة بولاية العهد على غرار القيصرية أو الكسروية ممّا لم يعهده المسلمون بعد، بل أنكروه أشدّ الإنكار. وهو بعد لم يفرض على الأرض بقوّة كقوّة معاوية.
واحتمال التغلّب عليه بسبب نقمة الناس لخلافته كان وارداً بنظر عامّة الناس، وإنّما كان التخوف من قبل بعض الخاصة لحسابات منطقية لا يدركها الجمهور.
ومجرّد علم الإمام (عليه السّلام) بعدم شرعية خلافة معاوية لا يكفي في ترتيب الأثر على تضحيته، ما لم تكن نظرته مدعومة بالرأي الإسلامي العام ولو في الجملة.
وثانياً : لأنّ الإمام الحسن (صلوات الله عليه) في موقع الصراع على السلطة، والدفاع العسكري عن خلافة قد ثبتت له ببيعة أهل الكوفة بنظر جمهور المسلمين، وبالنصّ عند الخاصة من شيعته بناءً على نظرية لم تأخذ موقعها المناسب عند جمهور المسلمين.
وليس هو كالإمام الحسين (صلوات الله عليه) في موقف الامتناع من البيعة والإنكار للمنكر، قانعاً بأن يترك من دون أن يقود حرباً إنّما فرضت
الحرب عليه فرضاً.
وبعبارة أخرى: الإمام الحسن (عليه السّلام) كان يقود حرباً خاسرة بنظر الناس، لا يبرّرها إلّا الإصرار الانفعالي والعناد، وليس كالإمام الحسين (عليه السّلام) في موقف الدفاع في حرب ظالمة تريد أن تفرض عليه بيعة يأباها، ولا مبرّر لإلزامه بها، بل هي فاقدة للشرعية بمقتضى الموازين المعروفة بين المسلمين آنذاك.
وثالثاً : لما ذكرناه آنفاً من أنّ دعوة التشيّع في أمسّ الحاجة لخواص الشيعة الذين سوف تأكلهم الحرب، أو يجتثّون عن جديد الأرض.
ورابعاً : لما سبق أيضاً من أنّ معاوية ليس كيزيد في طيشه وعنجهيته، فهو - على الظاهر - لا يقوم كما قام يزيد بكثير من الجرائم الوحشية التي زادت في فظاعة فاجعة الطفّ، وتأثيرها في نفوس المسلمين ضدّ الحكم الأموي.
بل من القريب جدّاً أن يستبقي معاوية الإمام الحسن (صلوات الله عليه) وأهل بيته لوحدهم بعد أن يقضي على أنصارهم كما سبق، وسبق بيان آثاره السلبية.
وخامساً : لأنّ تجربة الحكم الأموي المرّة في عهد معاوية الطويل قد زادت في مبرّرات الخروج عليه من قِبَل الإمام الحسين (صلوات الله عليه) في نظر عامّة المسلمين عمّا كان عليه في عهد الإمام الحسن (صلوات الله عليه) قبل مرور تلك التجربة.
وسادساً : لأنّ ظهور الاستهتار بالدين، والاستهانة بالقيم في يزيد أكثر من ظهورهما في معاوية بنظر عامّة الناس... إلى غير ذلك ممّا يظهر للمتأمّل، ويتّضح به الفرق الشاسع بين ظروف الإمامين (صلوات الله عليهما) المستتبع للفرق بينهما في المواقف، وفي أهمية التضحية ومبرّراتها، والآثار المترتبة عليها لصالح الدين.
تأييد الإمام الحسين (عليه السّلام) لموقف الإمام الحسن (عليه السّلام)
ولذا نرى الإمام الحسين (عليه السّلام) يؤيّد موقف الإمام الحسن (عليه السّلام)، ويدخل فيما دخل فيه، ويبقى على ذلك الموقف بعد وفاة الإمام الحسن (صلوات الله عليه) عشر سنين مع معاوية.
ولمّا امتنع (صلوات الله عليه) من الاستجابة لمعاوية في البيعة ليزيد بولاية العهد، وعرف رفضه (عليه السّلام) لها تطلّعت الشيعة لخلع معاوية، وكتب إليه جعدة بن هبيرة من الكوفة كتاباً يقول فيه:
أمّا بعد، فإنّ من قبلنا من شيعتك متطلّعة أنفسهم إليك، لا يعدلون بك أحداً. وقد كانوا عرفوا رأي أخيك الحسن في دفع الحرب، وعرفوك باللين لأوليائك، والغلظة على أعدائك، والشدّة في أمر الله. فإن كنت تحبّ أن تطلب هذا الأمر فاقدم علينا؛ فقد وطّنا أنفسنا على الموت معك.
فأجابه الإمام الحسين (صلوات الله عليه) بكتاب أعمّه إلى جميع أهل الكوفة يقول فيه: «أمّا أخي فأرجو أن يكون الله قد وفّقه وسدّده فيما يأتي، وأمّا أنا فليس رأيي اليوم ذلك؛ فالصقوا رحمكم الله بالأرض، واكمنوا في البيوت، واحترسوا من الظنّة مادام معاوية حي. فإنّ يحدث الله به حدثاً وأنا حي كتبت إليكم برأيي. والسّلام»(١) .
عظمة الإمام الحسن (عليه السّلام) في موقفه
والإنصاف أنّ النظرة الموضوعية لظروف الإمام الحسن (صلوات الله عليه) تقضي بعظمة موقفه الجريء في خدمة الدين، وفنائه في ذات الله (عزّ
____________________
١ - الأخبار الطوال/٢٢٢ موت الحسن بن علي.
وجلّ) من أجل ذلك؛ لأنّه أقدم بموقفه هذا على أن يتجرّع الأذى والغصص من معاوية وأتباعه، ويتعرّض للتشنيع عليه بالجبن وحبّ العافية ونحوهما من أعدائه ومن جهلة الناس.
كما يتعرّض للّوم والتقريع من شيعته وأوليائه؛ لقِصَر نظرهم وجهلهم بوجه الحكمة في موقفه بحيث يصعب تفهمّهم له واقتناعهم به.
ويمكن التعرّف على مرارة ما كان يقاسيه (عليه السّلام) ممّا روي عن هزان، قال: قيل للحسن بن علي: تركت إمارتك وسلّمتها إلى رجل من الطلقاء، وقدمت المدينة! فقال: «إنّي اخترت العار على النار»(١) .
فإنّ هذا الحديث إن صدق فأيّ معاناة كان (عليه السّلام) يعانيها وهو يرى نفسه - مع جلالته ورفعة مقامه - قد جنى العار بصلحه، وإن كان كذباً وافتراءً عليه (عليه السّلام) فما أعظم معاناته وهو يرى أنّه قد تعرّض لأن يرميه الأعداء والجاهلون بتحمّل العار، والرضا به.
فهو (صلوات الله عليه) في صبره على ذلك كلّه من أجل صلاح الدين قد بلغ القمّة في الجهاد في سبيل الله تعالى والفناء في ذاته، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.
فجزاه الله (عزّ وجلّ) عن دينه وأوليائه خير جزاء المحسنين، والسّلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً، ورحمة الله وبركاته وصلواته وتحياته، أنّه حميد مجيد.
____________________
١ - تاريخ دمشق ١٣/٢٦٦ في ترجمة الحسن بن علي بن أبي طالب، واللفظ له، ترجمة الإمام الحسن (عليه السّلام) من طبقات ابن سعد/٨١ ح ١٤٠.
المقام الثاني
في عدم مواجهة الإمام الحسن (عليه السّلام)
لمعاوية بعد ظهور غدره
من الظاهر أنّ معاوية قد أعلن من يومه الأوّل عن عدم التزامه بشروط الصلح، وقد سبق أنّه خطب في النخيلة عندما ورد الكوفة بعد الصلح، فقال في جملة ما قال: ألا إنّ كلّ شيء أعطيته الحسن بن علي تحت قدمي هاتين، لا أفي به(١) .
ومن المعلوم أنّ تصريح معاوية هذا وإن كان - في واقعه - مبرّراً للإمام الحسن (صلوات الله عليه) في تخليه عن الصلح، بغض النظر عمّا يأتي التعرّض له، إلّا إنّ الأوضاع والموانع السابقة لم تتغيّر لصالحه بحيث يستطيع التخلّي عن الصلح وإعلان الحرب.
بل ربما زادت الأوضاع سوءاً بعد انفراط جيش الإمام (عليه السّلام)، ووصول معاوية بجيشه في راحة إلى مشارف الكوفة، وظهور الشقاق بين أصحاب الإمام؛ لاختلاف وجهات نظرهم من الصلح.
ومن القريب أنّ معاوية أدرك ذلك، فأعلن موقفه المذكور من الشروط، وإلاّ فمن البعيد جدّاً أن يغامر ويتسرّع من دون أن يأمن من مغبّة عمله.
____________________
١ - تقدّمت مصادره في/٤٧٤.
نعم، بطول المدّة ربما تكون الأوضاع قد تغيّرت لصالح الإمام الحسن (صلوات الله عليه) من جهتين:
الأولى : تركّز عقيدة الشيعة عقائدياً في الجملة بحيث لا يخشى من انهيارها بتضحية جملة من خواص الشيعة مع الإمام الحسن (عليه السّلام)، كما ضحّوا أخيراً مع الإمام الحسين (عليه السّلام).
الثانية : تشوّه صورة الحكم الأموي؛ نتيجة استهتار معاوية بقيم المسلمين وحقوقهم، وظهور نقضه للعهد عملياً، وتعديه على أهل البيت (صلوات الله عليهم) وعلى شيعتهم.
تحرّك الشيعة في حياة الإمام الحسن (عليه السّلام)
ولعلّ ذلك هو الذي حمل جماعة من الشيعة في الكوفة على أن يراجعوا الإمام الحسن (صلوات الله عليه)، ويطلبوا منه الخروج على معاوية.
فعن أبي الكنود عبد الرحمن بن عبيد أنّه قال: لما بايع الحسن بن علي معاوية أقبلت الشيعة تتلاقى بإظهار الأسف والحسرة على ترك القتال؛ فخرجوا إليه بعد سنتين من يوم بايع معاوية، فقال له سليمان بن صرد الخزاعي: ما ينقضي تعجبّنا من بيعتك معاوية ومعك أربعون ألف مقاتل من أهل الكوفة كلّهم يأخذ العطاء، وهم على أبواب منازلهم، ومعهم مثلهم من أبنائهم وأتباعهم سوى شيعتك من أهل البصرة وأهل الحجاز، ثمّ لم تأخذ لنفسك ثقّة في العقد، ولا حظّاً في العطية...، ولكنّه أعطاك شيئاً بينك وبينه ثمّ لم يفِ به، ثمّ لم يلبث أن قال على رؤوس الناس: إنّي كنت شرطت شروطاً، ووعدت عدات إرادة لإطفاء نار الحرب، ومداراة لقطع هذه الفتنة. فأمّا إذا جمع الله لنا الكلمة والألفة، وآمننا من الفرقة فإنّ ذلك تحت قدمي. فوالله ما اغترّني بذلك إلّا ما كان بينك وبينه وقد
نقض. فإذا شئت فأعد الحرب جذعة، وأنذر(١) لي في تقدّمك إلى الكوفة، فأخرج عنها عاملها، وأظهر خلعه، وتنبذ إليهم على سواء؛ إنّ الله لا يحبّ الخائنين. وقال الآخرون مثل ما قال سليمان بن صرد.
فقال لهم الإمام الحسن (صلوات الله عليه): «أنتم شيعتنا، وأهل مودّتنا. فلو كنت بالحزم في أمر الدنيا أعمل، ولسلطانها أربض وأنصب، ما كان معاوية بأبأس منّي بأساً، ولا أشدّ شكيمة، ولا أمضى عزيمة، ولكنّي أرى غير ما رأيتم، وما أردت فيما فعلت إلّا حقن الدم؛ فارضوا بقضاء الله، وسلّموا لأمره، والزموا بيوتكم، وأمسكوا، أو قال: كفّوا أيديكم حتى يستريح برّ أو يُستراح من فاجر»(٢) .
وربما يكون تمسّكه (عليه أفضل الصلاة والسّلام) بموقفه وإصراره على الموادعة؛ من أجل أنّ الأوضاع وإن تغيّرت لصالحه (عليه السّلام) من الجهتين السابقتين إلّا إنّها لم تتغيّر من بقيّة الجهات السابقة، بل زاد في المشكلة أمران:
تقوية معاوية لسلطانه في فترة حكمه
الأوّل: إنّ معاوية وإن استهتر بقيم المسلمين وحقوقهم، إلّا إنّه اشترى ضمائر كثير من ذوي المكانة والنفوذ في المجتمع، كما إنّه أحكم أمر سلطانه، وزاد في قوّة دولته بالترغيب والترهيب بنحو قد لا يتهيّأ استجابة فئة معتدٍ بها للإمام الحسن (صلوات الله عليه) كما حصل للإمام الحسين (صلوات الله عليه)؛ حيث استجابت له فئة كبيرة من الناس بحيث كان خروجه مبرّراً نسبياً، وإن
____________________
١ - هكذا ورد في الطبعة المعتمد عليها، ولكن الوارد في طبعة دار اليقظة العربية تحقيق: محمود فردوس العظم ج: ٢ ص: ٣٩١ «وائذن لي».
٢ - أنساب الأشراف ٣/٢٩٠ - ٢٩١ أمر الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام)، واللفظ له، الإمامة والسياسة ١/١٣٣ - ١٣٤ إنكار سليمان بن صرد.
غدروا به بعد ذلك، أو عجزوا عن الالتحاق به ونصره.
استغلال معاوية للعهد
الثاني: إنّ الإمام الحسن (صلوات الله عليه) كان مقيّداً مع معاوية بصلح وميثاق يمنعه من الخروج عليه والمواجهة معه.
ونقض معاوية للشروط وإن كان مبرّراً شرعياً وواقعياً لخروج الإمام (عليه السّلام) عن الصلح، إلّا إنّ معاوية بما يملك من قوى إعلامية وتثقيفية هائلة يستطيع أن يغفل عامّة المسلمين عن جريمته في البدء بنقض الشروط، ويظهر الإمام الحسن (صلوات الله عليه) بمظهر الناقض للعهد؛ من أجل أن يكثّف القوى ضدّه.
كما إنّه بذلك يضعف قوّة الإمام (عليه السّلام) المعنوية، ويشوّه صورته بنحو يتنافى مع مقام الإمام الرفيع في القدسية والمبدئية والمثالية، وصورة الدعوة الشريفة التي يتبنّاها (صلوات الله عليه) بحيث يضرّ بها عقائدياً.
وبعبارة أُخرى: لا يكفي في الحفاظ على قدسية رموز الدين وقدسية دعوتهم - بحيث تأخذ موقعها المناسب عقائدياً - الحفاظ على المبادئ والمثالية واقعاً، وفي علم الله تعالى، بل لا بدّ مع ذلك من البعد من مواقع التهم، وتجنّب كلّ ما يمكن أن يستغله الخصوم في تشويه صورتهم وإن ابتنى على تجاهل الحقائق والكذب والبهتان والتهريج غير المسؤول.
ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه حينما طلبوا منه قتل عبد الله بن أُبي - بعد أن أعلن بمواقفه السلبية منه ومن دعوته - قال: «لا يتحدّث الناس أنّ محمداً يقتل أصحابه»(١) .
____________________
١ - صحيح البخاري ٦ كتاب التفسير، باب تفسير سورة المنافقين/٦٥ باب قوله سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين،/٦٧ باب يقولون لئن =
ولما عرضوا عليه أن يقتل مَنْ نفّر ناقته وحاول إلقاءه في العقبة قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا. أكره أن تتحدّث العرب بينها أنّ محمداً قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم...»(١) .
ولمّا نقض معاوية شروط الموادعة مع أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسّلام) وأخذ يشنّ الغارات على بلاده خطب أمير المؤمنين (عليه السّلام)، فقال: «ما لمعاوية قاتله الله؟! لقد أرادني على أمر عظيم. أراد أن أفعل كما يفعل؛ فأكون قد هتكت ذمّتي، ونقضت عهدي، فيتّخذها عليّ حجّة، فتكون عليّ شيناً إلى يوم القيامة كلّما ذُكرت. فإن قيل له: أنت بدأت. قال: ما علمت ولا أمرت. فمن قائل يقول: قد صدق. ومن قائل يقول: كذب. أمَ والله، إنّ الله لذو أناة وحلم عظيم. لقد حلم عن كثير من فراعنة الأوّلين، وعاقب فراعنة، فإن يمهله الله فلن يفوته، وهو له بالمرصاد على مجاز طريقه. فليصنع ما بدا له، فإنّا غير غادرين بذمتنا، ولا ناقضين لعهدنا، ولا مروعين لمسلم ولا معاهد حتى ينقضي شرط الموادعة بيننا إن شاء الله»(٢) .
ونظير ذلك ما سبق في أواخر المقصد الأوّل - عند الكلام في تبدّل موقف السلطة من فاجعة الطفّ ومحاولتها التنصّل منها - من كلام معاوية مع عبيد الله بن العباس في التنصّل ممّا فعله بسر بن أرطاة وقتله لولديه(٣) .
____________________
= رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعزّ منها الأذلّ ولله العزّة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، صحيح مسلم ٨/١٩ كتاب البرّ والصلّة والآداب، باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً، وغيرهما من المصادر الكثيرة.
١ - تفسير ابن كثير ٢/٣٨٦ - ٣٨٧، واللفظ له، البداية والنهاية ٥/٢٥ في أحداث سنة تسع من الهجرة، تخريج الأحاديث والآثار - للزيلعي ٢/٨٤ الحديث الخامس والثلاثون، الدرّ المنثور ٣/٢٦٠، تاريخ الإسلام ٢/٦٤٨ في فائدة، السيرة الحلبية ٣/١٢١، وغيرها من المصادر.
٢ - الإرشاد ١/٢٧٥ - ٢٧٦، بحار الأنوار ٣٤/١٥٢ - ١٥٣.
٣ - تقدّم في/١٣١.
وعلى ذلك فمعاوية وإن جدّ في نقض الشروط التي بينه وبين الإمام الحسن (صلوات الله عليه)، إلّا إنّ الإمام (عليه السّلام) لو استعمل حقّه الواقعي وخرج عليه لأغفل معاوية ما سبق منه، وسلّط الأضواء على موقف الإمام (صلوات الله عليه)، وركّز إعلامه عليه، وأخذ يشنّع على الإمام (عليه السّلام) بأنّه قد نقض العهد، وخاس بشرطه، وجنّد قوّته الإعلامية الهائلة، ورواة السوء من أجل ذلك بحيث يخدش في قدسية الإمام (صلوات الله عليه)، وقدسية دعوته، ويزعزع بعدهما العقائدي.
وهي طريقة المبطلين المألوفة في صراعهم مع غيرهم، وما أكثر مفردات ذلك، بل نحن قد عشنا ولازلنا نعيش مع بعض تلك المفردات.
وهذا معاوية نفسه كتب له مروان أنّه لا يأمن وثوب الإمام الحسين (صلوات الله عليه)، فكتب للإمام (عليه السّلام): أمّا بعد، فقد انتهت إليّ أمور عنك إن كانت حقّاً - فقد أظنّك تركتها رغبة - فدعها. ولعمر الله إنّ مَنْ أعطى الله عهده وميثاقه لجدير بالوفاء...، وعظ نفسك فاذكر، ولعهد [وبعهد.خ] الله أوف.... وهو بذلك يغفل بدءه بنقض العهد.
ولذا أجابه الإمام الحسين (صلوات الله عليه) بكتاب يقول فيه بعد كلام طويل يتضمّن استعراض موبقاته، ومنها قتله لجماعة من الشيعة: «إنّك قد ركبت بجهلك، وتحرّضت [تحرصت] على نقض عهدك. ولعمري، ما وفيت بشرط، ولقد نقضت عهدك بقتلك هؤلاء النفر الذين قتلتهم بعد الصلح والأيمان والعهود والمواثيق...»(١) .
____________________
١ - اختيار معرفة الرجال ١/١٢٠ - ١٢٤ عند ذكر عمرو بن الحمق، وقد ذكر الكتابين بتغيير يسير واختصار في تاريخ دمشق ١٤/٢٠٥ - ٢٠٦ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، وتهذيب الكمال ٦/٤١٣ - ٤١٤ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، وتاريخ الإسلام ٥/٦ في أحداث سنة واحد وستين من الهجرة، مقتل الحسين، والبداية والنهاية ٨/١٧٤ أحداث سنة =
فإذا كان هذا خطابه للإمام الحسين (عليه السّلام) الذي عانى من مرارة خروقاته للعهود والمواثيق، واستهانته بها، فكيف يكون خطابه لعامّة الناس مع ما يملك من قوى إعلامية هائلة، وأعوان نفعيين لا يبالون بتشويه الحقيقة وتحريفها لصالح مشروعه الجهنمي؟!
والحاصل: إنّ الإمام الحسن (صلوات الله عليه) لم يكن مع معاوية في وضع يسمح له بالتضحية والفداء كما فعل الإمام الحسين (صلوات الله عليه) مع يزيد، فضلاً عن أن يدخل في صراع مع معاوية من أجل إصلاح الأوضاع وتعديل مسيرة الإسلام التي انحرفت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزاد انحرافها في عهد معاوية كما هو الوضع الطبيعي في كلّ انحراف.
وإذا كان كثير من الشيعة في الكوفة قد حاولوا حمل الإمام الحسن (عليه السّلام) على الثورة والتغيير بعد نقض معاوية للعهد وسوء سيرته فيهم؛ فذلك منهم ناشئ عن فقدهم النظرة الموضوعية نتيجة تأجّج عاطفتهم نحو أهل البيت (صلوات الله عليهم) وشدّة أسفهم لاعتزالهم السلطة، وإنكارهم سوء سيرة معاوية؛ ولذا لم يستجب الإمام (عليه السّلام) لهم وإن طيّب خواطرهم وأثنى عليهم.
موقف الإمام الحسين (عليه السّلام) في عهد معاوية بعد أن تقلّد الإمامة
وبذلك يظهر تعذّر كلا الأمرين أيضاً من الإمام الحسين (صلوات الله عليه) في عهد معاوية بعد تقلّده للإمامة خلفاً لأخيه الإمام الحسن (صلوات الله عليه)؛ فإنّ جميع ما سبق في وجه تعذّر خروج الإمام الحسن (عليه السّلام) على معاوية جارٍ في حقّه (عليه السّلام)؛ حيث لم يتغيّر شيء كما هو ظاهر.
وقد سبق منه (صلوات الله عليه) في جوابه لكتاب أهل الكوفة التصريح
____________________
= ستين من الهجرة، صفة مخرج الحسين إلى العراق، وغيرها من المصادر.
١ - تدّم في/٤٦٥.
بامتناعه عن الخروج مادام معاوية حيّاً(١) ، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم، وإليه يرجع الأمر كلّه.
____________________
١ - تقدّم في/٤٨٢.
الفصل الثالث
في موقف الأئمّة من ذرية الحسين (عليه السّلام)
أوضحنا فيما سبق تعذّر الإصلاح وإرجاع السلطة في الإسلام إلى مسارها الصحيح بعد الانحراف الذي حصل، وأنّ الأئمّة (صلوات الله عليهم) كلّهم على بصيرة من ذلك من اليوم الأوّل وإن لم يتسنَّ لهم التصريح به، والتأكيد عليه إلّا بعد فاجعة الطفّ.
لا موجب للتضحية بعد فاجعة الطفّ
وأمّا التضحية بالنحو الذي أقدم عليه الإمام الحسين (صلوات الله عليه) في نهضته المباركة، فلا مجال لها من الأئمّة من ذريته (عليهم السّلام).
لما سبق من أنّ دوافع التضحية المذكورة ليست انفعالية مزاجية، أو نتيجة التنفّر من الفساد والانحراف، أو لمجرد الإباء والشمم، أو نحو ذلك؛ ليشاركوا (عليهم السّلام) الإمام الحسين (صلوات الله عليه) فيه، أو في شيء منه، بل لا بدّ من كون الهدف منها مكاسب للدين الحنيف تناسب حجم التضحية.
وقد سبق أنّ الذي ظهر لنا من فوائد نهضة الإمام الحسين (عليه السّلام) وثمراتها هو إكمال مشروع أمير المؤمنين (عليه السّلام) في إيضاح معالم الدين، وسلب شرعية السلطة التي كانت تتحكّم فيه، وتركيز دعوة التشيّع، ودفعها باتجاه التوسّع والانتشار.
وبعد حصول ذلك كلّه بجهود الأئمّة الأوّلين (عليهم السّلام) وخاصة شيعتهم،
وتضحياتهم التي بلغت القمّة في فاجعة الطفّ، لا يبقى مبرّر للتضحية من الأئمّة الباقين (عليهم السّلام) أو من شيعتهم.
ولاسيما بعد أن فُتِح بعد فاجعة الطفّ باب الإنكار على السلطة وتعريته، والتذكير بجرائمه، والتأكيد على عدم شرعيته من قبل فئات كثيرة غير الشيعة الإمامية، وبدأ الخروج عليها حتى من غير الخوارج.
اهتمام الأئمّة (عليهم السّلام) بالحفاظ على شيعتهم
ولذا بدأوا (صلوات الله عليهم) يحثّون شيعتهم على أن يحافظوا على أنفسهم، ويحقنوا دماءهم، ولا يتعرّضوا للسلطان، ولا يذلّوا أنفسهم بالاحتكاك به، وظهور مخالفتهم له، ويتجنّبوا الجدل والخصومة مع الجمهور، ويبعدوا عن مظان الشهرة، ويحذروا من التعرّض لتشهير الناس بهم وتهريجهم عليهم.
وأكّدوا على التقيّة في الدين، وكتمان الحقّ عن غير أهله، وتجرّع الغيظ والصبر على ما يقاسونه من أعدائهم... إلى غير ذلك ممّا يجري هذا المجرى.
وما ورد عنهم (عليهم أفضل الصلاة والسّلام) في ذلك من الكثرة بحيث يتعذّر استيعابه هنا، ويسهل التعرّف عليه بأدنى مراجعة لتراثهم الثقافي الرفيع، وملاحظة لسلوكهم (عليهم السّلام) وسلوك خواصّ أصحابهم.
وقد استطاعوا بذلك أن يكبحوا جماح غضب الشيعة وانفعالهم، ويحدّوا من اندفاعاتهم الانفعالية والعاطفية؛ حفاظاً عليهم.
كلّ ذلك لشدّة اهتمامهم (صلوات الله عليهم) ببقاء المؤمنين وتكثيرهم من أجل أن يؤدّوا ما عليهم من حمل دعوة الحقّ والحفاظ عليها والتبليغ به، وتجسيد تعاليمها عملاً؛ كي تبقى حيّة فاعلة جيلاً بعد جيل.
اهتمام الأئمّة (عليهم السّلام) بتقوية كيان الشيعة
وبعد ذلك انصبّت جهود الأئمّة (عليهم أفضل الصلاة والسّلام) - بعهد من الله (عزّ وجلّ) ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وتوجيه منهما - على تقوية كيان التشيّع وبلورة مفاهيمه، واستثمار مكاسبه السابقة لصالح دعوته الشريفة، وذلك بأمور:
التأكيد على تعذّر تعديل مسار السلطة ولزوم مهادنتها
الأوّل: التأكيد على الحقيقة السابقة، وإقناع الشيعة بها، وهي تعذّر إقامة الحكم الصالح، وتعديل مسار السلطة في الإسلام بعد الانحراف الذي حصل، وما ترتّب عليه من سلبيات في المجتمع الإسلامي.
وإنّه نتيجة لذلك صاروا هم (صلوات الله عليهم) وأتباعهم في هدنة مع السلطة الغاشمة حتى قيام الإمام الثاني عشر، الحجّة المهدي المنتظر (عجّل الله تعالى فرجه الشريف).
من دون أن يغفلوا (عليهم السّلام) جور السلطة الظالمة، وعدم شرعيتها، ووجوب مباينتها، وحرمة التعاون معها والركون إليها، وما جرى مجرى ذلك ممّا يؤكّد الحاجز النفسي بينهم وبينها.
ثمرات مهادنة السلطة
وكان نتيجة المهادنة المذكورة، وعدم التصدّي لمواجهة الحاكم، وظهور ذلك عنهم (عليهم السّلام) وعن شيعتهم أن كسب التشيّع:
أوّلاً : عدم التفريط بقدرات الشيعة وطاقاتهم، وصرفها في محاولات غير مجدية، بل قد تعود عليهم بأضرار فادحة، وتوجيه تلك القدرات والطاقات الهائلة لما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ويركّز دعوتهم الحقّة ويشيدها.
بل انصراف الشيعة عن الصراع السياسي والعسكري يجعلهم - من حيث يريدون أو لا يريدون - أحرص على نشاطاتهم الدينية - خصوصاً المذهبية منها - من أجل التنفيس عن كبتهم، وتثبيت هويتهم وشخصيتهم، وإثبات وجودهم، كردّ فعل صامت على مواقف السلطات المتعاقبة ضدّهم، وجورها عليهم.
وثانياً : تخفيف ضغط السلطات على الشيعة والتشيّع نسبياً رغم ابتناء الإمامة عند الشيعة على عدم شرعية تلك السلطات، وقيام الشيعة بكثير من الممارسات التي لا تعجبه، وعدم تجاوبهم مع كثير من ممارسات السلطة، بل استنكارهم لبعضها ولو برفق وهدوء.
وذلك لانشغال السلطة عنهم بمكافحة المعارضة المسلحة التي تهدّدها بالمباشرة، وإلى ذلك يشير ما ورد عنهم (صلوات الله عليهم) من أنّ الله (عزّ وجلّ) جعل الزيدية وقاء للشيعة(١) .
وحتى لو تفرّغ الحاكم للشيعة، وحاول التنكيل بهم - كما حدث كثيراً - فإنّه يعدّ لدى المنصف ظالماً بعد أن لم يمارسوا الكفاح المسلح، ولا ينازعونه سلطانه، وذلك يرفع معنوياتهم في أنفسهم، ويوجب تعاطف الناس معهم، وكلاهما مكسب مهمّ في حساب المبادئ.
التركيز على فاجعة الطفّ وعلى ظلامة أهل البيت (عليهم السّلام)
الثاني: التركيز على فاجعة الطفّ وعلى الجانب العاطفي منها بالخصوص، والانطلاق من ذلك للتذكير بظلامة أهل البيت (صلوات الله عليهم)، وظلامة الحقّ الذي يحملونه ويدعون إليه، ولشجب الظالمين، والإنكار عليهم، والتنفير منهم.
ثمّ تثبيت هوية التشيّع في التولّي لأولياء الله (عزّ وجلّ)، والبراءة من أعدائه
____________________
١ - الغيبة - للنعماني/٢٠٤، بحار الأنوار ٥٢/١٣٩.
وأعداء أهل البيت (عليهم السّلام) وظالميهم وغاصبي حقوقهم، والاهتمام بالحقيقة من أجل الحقيقة، لا من أجل المكاسب المادية.
وكان الأئمّة (صلوات الله عليهم) يتحرّون المناسبات المختلفة للتذكير بالفاجعة، وللتفاعل بها، ويؤكّدون على إحيائها بالحثّ على قول الشعر في الإمام الحسين (صلوات الله عليه)، والبكاء عليه، والتأكيد على أهمية الدمعة في ذلك، والقيام بمظاهر الحزن المختلفة من أجله (عليه السّلام)، وحضور مجالس العزاء.
مع بيان عظيم أجر ذلك وجزيل ثوابه بوجه مذهل، كلّ ذلك في نصوص وممارسات كثيرة منهم (عليهم السّلام) تفوق حدّ الإحصاء.
وبذلك فتحوا لشيعتهم الباب لأمرين لم يألفهما عامّة المسلمين ولو بسبب الظروف الخانقة، والفتن المتلاحقة والعصبية العمياء التي أذهلتهم عن التعرّف على واقع دينهم، والأخذ بتعاليمه الحقّة التي رووها(١) ، وأمروا بالرجوع فيها لأهل البيت (صلوات الله عليهم).
____________________
١ - فقد روى الجمهور الحثّ على زيارة قبور أهل البيت (صلوات الله عليهم) والإمام الحسين (عليه السّلام) خاصة، راجع مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/١٦٦ - ١٧٢ الفصل الرابع عشر في ذكر زيارة تربة الحسين صلوات الله عليه وفضله، وذخائر العقبى/١٥١ ذكر ما جاء في زيارة قبر الحسين بن علي (رضي الله عنهم)، والفتوح - لابن أعثم ٤/٣٣١ - ٣٣٢ ابتداء أخبار مسلم بن عقيل والحسين بن علي وولده وشيعته من ورائه، وأهل السُنّة وما ذكروا في ذلك من الاختلاف، وغيرها من المصادر.
كما روى الجمهور أيضاً استحباب صوم يوم الغدير تجديداً؛ لذكرى نصب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين (عليه السّلام) وإعلان ولايته. تاريخ بغداد ٨/٢٨٤ في ترجمة حبشون بن موسى بن أيوب، تاريخ دمشق ٤٢/٢٣٣ في ترجمة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، البداية والنهاية ٥/٢٣٣ في فصل لم يسمه، وج ٧/٣٨٦ في حديث غدير خم، السيرة النبوية - لابن كثير ٤/٤٢٥ فصل في إيراد الحديث الدال على أنّه (عليه السّلام) خطب بمكان بين مكة والمدينة مرجعه من حجّة الوداع يُقال له غدير خم، شواهد التنزيل ١/٢٠٠، ٢٠٣، وغيرها من المصادر.
التأكيد على زيارة الإمام الحسين (عليه السّلام) وجميع أهل البيت (عليهم السّلام)
أحدهما : زيارة الإمام الحسين (صلوات الله عليه)، ومنها انطلقوا لزيارة جميع المعصومين (صلوات الله عليهم)، وزيارة كثير من أبنائهم والأبرار من أوليائهم؛ مذكّرين بأحاديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك.
مع تأكيد مكثف منهم (عليهم السّلام) على ذلك لا يسعنا استقصاؤه، إلّا إنّه يحسن بنا أن نثبت حديثاً واحداً يتضمّن جوانب مثيرة وملفتة للنظر.
حديث معاوية بن وهب
فقد روي بطرق كثيرة عن معاوية بن وهب قال: استأذنت على أبي عبد الله (عليه السّلام) فقيل لي: ادخل. فدخلت فوجدته في مصلاّه في بيته، فجلست حتى قضى صلاته، فسمعته وهو يناجي ربّه، وهو يقول:
«اللّهمّ يا مَنْ خصّنا بالكرامة، ووعدنا بالشفاعة، وخصّنا بالوصية، وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقي، وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا.
اغفر لي ولإخواني وزوّار قبر أبي عبد الله الحسين الذين أنفقوا أموالهم، وأشخصوا أبدانهم رغبة في برّنا، ورجاءً لما عندك في صلتنا، وسروراً أدخلوه على نبيّك، وإجابة منهم لأمرنا، وغيظاً أدخلوه على عدونا، أرادوا بذلك رضوانك.
فكافهم عنّا بالرضوان، واكلأهم بالليل والنهار، واخلف على أهاليهم وأولادهم الذين خلفوا بأحسن الخلف وأصحبهم، وأكفّهم شرّ كلّ جبار عنيد، وكلّ ضعيف من خلقك وشديد، وشرّ شياطين الإنس والجن، وأعطهم أفضل ما أمّلوا منّك في غربتهم عن أوطانهم، وما آثرونا به على أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم.
اللّهمّ إنّ أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم، فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا خلافاً منهم على مَنْ خالفنا.
فارحم تلك الوجوه التي غيّرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تتقلّب على حفرة أبي عبد الله الحسين (عليه السّلام)، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا.
اللّهمّ إنّي أستودعك تلك الأبدان وتلك الأنفس حتى توافيهم [ترويهم] من الحوض يوم العطش [الأكبر]».
فمازال يدعو وهو ساجد بهذا الدعاء، فلمّا انصرف قلت: جعلت فداك، لو أنّ هذا الذي سمعت منك كان لمَنْ لا يعرف الله (عزّ وجلّ) لظننت أنّ النار لا تطعم منه شيئاً أبداً. والله، لقد تمنّيت إنّي كنت زرته ولم أحج. فقال لي: «ما أقربك منه، فما الذي يمنعك من زيارته؟».
ثمّ قال لي: «يا معاوية، ولِمَ تدع ذلك؟». قلت: جعلت فداك، لم أدرِ أنّ الأمر يبلغ هذا كلّه. فقال: «يا معاوية، مَنْ يدعو لزوّاره في السماء أكثر ممّنْ يدعو لهم في الأرض»(١) .
ويبدو أنّ الشيعة أو عموم المسلمين اندفعوا لذلك من اليوم الأوّل بصورة مكثفة، وكأنّهم كانوا مهيئين إلى أنّه إذا قُتل الإمام الحسين (صلوات الله عليه) فينبغي أن يُزار، ويُحيى ذكره.
فقد ورد أنّ الإمام زين العابدين (صلوات الله عليه) حينما رجع بالعائلة الثاكلة من الشام إلى المدينة المنوّرة طلبوا من الدليل أن يمرّ بهم على كربلاء، فوصلوا
____________________
١ - كامل الزيارات/٢٢٨ - ٢٢٩، واللفظ له، الكافي ٤/٥٨٢ - ٥٨٣، ثواب الأعمال/٩٥، بحار الأنوار ٩٨/٨ - ٩.
إلى مصرع الإمام الحسين (عليه السّلام)، فوجدوا جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجماعة من بني هاشم ورجالاً من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد وردوا لزيارة قبر الإمام الحسين (صلوات الله عليه)، فتلاقوا بالبكاء والحزن واللطم، وأقاموا في كربلاء ينوحون على الإمام الحسين (عليه السّلام)(١) .
كما روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنّه جاء لزيارة الإمام الحسين (عليه السّلام)، وقام بالزيارة بآدابها على نحو ما ورد عن أهل البيت (عليهم السّلام) في مراسيم زيارته (صلوات الله عليه)(٢) ، وأنّه أوّل مَنْ زار الإمام الحسين (عليه السّلام)(٣) .
وعن نوادر علي بن أسباط عن غير واحد قال: لما بلغ أهل البلدان ما كان من أبي عبد الله (عليه السّلام) قدمت لزيارته مئة ألف امرأة ممّنْ كانت لا تلد، فولدنَ كلّهنّ(٤) .
تحقيق الوعد الإلهي ببقاء قبره الشريف علماً للمؤمنين
وكأنّ ذلك تحقيق للوعد الإلهي الذي تضمّنته النصوص الكثيرة، ومنها ما عن عقيلة بني هاشم زينب الكبرى (عليها السّلام)، بنت الإمام أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) حين مرّوا بهم على الإمام الحسين وأهل بيته وصحبه (صلوات الله عليهم) وهم مضرّجون بدمائهم، مرمّلون بالعراء؛ فضاق صدر الإمام زين العابدين (عليه السّلام) ممّا رأى، فأخذت تسلّيه، وقالت له: لا يجزعنّك ما ترى؛ فوالله إنّ ذلك لعهد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جدّك وأبيك وعمّك. ولقد أخذ
____________________
١ - اللهوف في قتلى الطفوف/١١٤، بحار الأنوار ٤٥/١٤٦.
٢ - بحار الأنوار ٦٥/١٣٠ - ١٣١، بشارة المصطفى/١٢٥ - ١٢٦، مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/١٦٧ - ١٦٨.
٣ - مصباح المتهجد/٧٨٧، مسار الشيعة/٤٦.
٤ - بحار الأنوار ٤٥/٢٠٠.
الله ميثاق أناس من هذه الأُمّة لا تعرفهم فراعنة هذه الأُمّة، وهم معروفون في أهل السماوات أنّهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرّقة فيوارونها، وهذه الجسوم المضرّجة، وينصبون لهذا الطفّ علماً لقبر أبيك سيد الشهداء لا يُدرس أثره، ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأيام، وليجتهدنّ أئمّة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه فلا يزداد أثره إلّا ظهوراً، وأمره إلّا علّواً.
ولمّا سألها الإمام زين العابدين (عليه السّلام) عمّا تعرفه من هذا العهد المعهود حدّثته بحديث أُمّ أيمن الطويل، وفيه يقول جبرئيل (عليه السّلام) للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ثمّ يبعث الله قوماً من أُمّتك لا يعرفهم الكفّار لم يشركوا في تلك الدماء بقول ولا فعل ولا نيّة، فيوارون أجسامهم، ويقيمون رسماً لقبر سيّد الشهداء بتلك البطحاء؛ يكون علماً لأهل الحقّ، وسبباً للمؤمنين إلى الفوز...، وسيجدّ أُناس حقّت عليهم من الله اللعنة والسخط أن يعفوا رسم ذلك القبر ويمحوا أثره فلا يجعل الله تبارك وتعالى لهم إلى ذلك سبيلاً»(١) .
وعلى كلّ حال فقد استمر شيعة أهل البيت (عليهم السّلام) على ذلك حتى صار في فترة قصيرة شعاراً لهم معروفاً عنهم يمتازون به عن غيرهم.
تجديد الذكرى بمرور السُنّة
ثانيهما : تجديد الذكرى بتعاقب السنين بحيث يكون وقت الفاجعة من السنة موسماً سنوياً يتجدّد فيه الأسى والحسرة، ومظاهر الحزن ونحو ذلك ممّا يناسب الذكرى الأليمة.
فقد ورد عنهم (عليهم السّلام) التأكيد على اتخاذ يوم عاشوراء يوم مصيبة وحزن وبكاء، مع التعطيل فيه، وعدم السعي لما يتعلّق بأمر الدنيا.
____________________
١ - راجع ملحق رقم (٦).
ففي حديث إبراهيم بن أبي محمود قال: قال الرضا (عليه السّلام): «إنّ المحرّم شهر كان أهل الجاهلية يحرّمون فيه القتال، فاستُحلت فيه دماؤنا، وهُتكت فيه حرمتنا، وسُبي فيه ذرارينا ونساؤنا، وأُضرمت النيران في مضاربنا، وانتُهب ما فيها من ثقلنا، ولم تُرعَ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرمة في أمرنا.
إنّ يوم الحسين أقرح جفوننا، وأسبل دموعنا، وأذلّ عزيزنا بأرض كرب وبلاء، أورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء؛ فعلى مثل الحسين فليبك الباكون؛ فإنّ البكاء يحطّ من الذنوب العظام».
ثمّ قال (عليه السّلام): «كان أبي (صلوات الله عليه) إذا دخل شهر المحرّم لا يُرى ضاحكاً، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى يمضي منه عشرة أيام، فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه، ويقول: هو اليوم الذي قُتل فيه الحسين صلوات الله عليه»(١) .
وفي حديث الحسن بن علي بن فضال عنه (عليه السّلام) قال: «مَنْ ترك السعي في حوائجه يوم عاشوراء قضى الله له حوائج الدنيا والآخرة، ومَنْ كان يوم عاشوراء يوم مصيبته وحزنه وبكائه جعل الله (عزّ وجلّ) يوم القيامة يوم فرحه وسروره، وقرّت بنا في الجنان عينه.
ومَنْ سمّى يوم عاشوراء يوم بركة وادّخر فيه لمنزله شيئاً لم يبارك له فيما ادّخر، وحُشر يوم القيامة مع يزيد وعبيد الله بن زياد وعمر بن سعد (لعنهم الله) إلى أسفل درك من النار»(٢) ... إلى غير ذلك ممّا ورد عنهم (صلوات الله عليهم).
____________________
١ - الأمالي - للصدوق/١٩٠، واللفظ له، إقبال الأعمال ٣/٢٨، بحار الأنوار ٤٤/٢٨٣ - ٢٨٤.
٢ - الأمالي - للصدوق/١٩١، بحار الأنوار ٤٤/٢٨٤.
وذلك لم يكن معروفاً قبل حادثة الطفّ إلّا ما ورد عن أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسّلام) في ذكرى يوم الغدير(١) ، لكنّه لم يأخذ موقعه المناسب عند الشيعة بسبب الانتكاسة والمحن التي مُني بها التشيّع بقتل أمير المؤمنين (عليه السّلام) حتى جدّده الأئمّة من ولده (صلوات الله عليهم) مذ قام للشيعة كيان ظاهر بعد فاجعة الطفّ، وتوجّهوا (عليهم السّلام) لتثقيف شيعتهم ونظم أمرهم.
وقد فتح ذلك الباب لتجديد الذكرى السنوية في جميع المناسبات المتعلّقة بالدين والمذهب في الأحزان والأفراح.
شدّ الشيعة نحو الإمام الحسين (عليه السّلام) بمختلف الوجوه
كما حاول الأئمّة (صلوات الله عليهم) تذكير الشيعة بالإمام الحسين (صلوات الله عليه) وشدّهم نحوه بمختلف الوجوه.
منها: تأكيدهم (عليهم السّلام) على تميّز تربته الشريفة بالسجود عليه، والتسبيح بها، ووضعها مع الميت في قبره، وغير ذلك من وجوه التبرّك والتكريم.
ومن أهمّها الاستشفاء بها؛ لما له من الآثار التي يدركها الناس باستمرار، ويرونها عياناً في وقائع كثيرة تفوق حدّ الإحصاء(٢) .
ومنها: تنبيههم إلى كرامة مشهده الشريف وتميّزه باستجابة الدعاء فيه، وتخيير المسافر في صلاته بين القصر والتمام، كمكّة المعظمّة والمدينة المنوّرة
____________________
١ - مصباح المتهجد/٧٥٤ - ٧٥٥.
٢ - قال جعفر الخلدي: كان بي جرب عظيم، فتمسّحت بتراب قبر الحسين فغفوت فانتبهت وليس عليّ منه شيء. المنتظم ٥/٣٤٦ - ٣٤٧ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام)، واللفظ له، بغية الطلب في تاريخ حلب ٦/٢٦٥٧ في ترجمة الحسين بن علي بن عبد مناف أبي طالب، الأمالي - للشجري ١/١٦٥ الحديث الثامن، في فضل الحسين بن علي (عليهم السّلام) وذكر مصرعه وسائر أخباره وما يتصل بذلك.
والكوفة، أو خصوص مسجده؛ فهو رابع المواضع المتميّزة بذلك؛ لكرامتها عند الله تعالى.
ومنها: تنبيههم إلى ظلامته (عليه السّلام) في منع ماء الفرات عنه حتى اشتدّ العطش به وبأطفاله وعائلته وبجميع مَنْ معه، ثمّ الحثّ على ذكره عند شرب الماء، والسّلام عليه ولعن قاتليه... إلى غير ذلك.
وعلى كلّ حال فقد تحوّلت هذه الأمور من ممارسات عابرة إلى شعارات صارخة يتميّز بها الشيعة عن غيرهم، وكان ثمرتها توحيد جماعتهم وتثبيت هويتهم، وتأكيد ولائهم لأهل البيت (صلوات الله عليهم)، وتمسّكهم بخطّهم، والبراءة من أعدائهم وظالميهم، على ما سبق عند الكلام فيما كسبه التشيّع من فاجعة الطفّ.
المدّ الإلهي والكرامات الباهرة
ويشدّ من عزمهم على ذلك كلّه الآيات الظاهرة، والكرامات الباهرة، والمعاجز الخارقة التي تضمّنها تراث الشيعة الرفيع، ولازالوا يرونها بأعينهم، ويعيشونها في واقعهم على امتداد الزمن، وقد بلغت من الكثرة والظهور بحيث أقرّ بها غيرهم قولاً وعملاً.
الحكمة في التأكيد المذكور
وقد يخفى وجه الحكمة في ذلك على فريق من الناس، ويرون أو يقولون: إنّ الهدف السامي لنهضة الإمام الحسين (صلوات الله عليه) التي انتهت بفاجعة الطفّ هو إصلاح المجتمع وتوجيهه نحو المبادئ السامية التي نهض الإمام الحسين (عليه السّلام) من أجلها، فاللازم الاهتمام بذلك. أمّا هذه الممارسات فهي لا تزيد
عن أن تكون تقاليد وعادات، لا أهميّة لها في تحقيق الهدف المذكور، ولا تستحق هدر هذه الطاقات الهائلة من أجله.
وقد سبق أن رفع شعار يقول: إنّ الحسين قُتل من أجل العِبرة، لا من أجل العَبرة. كما قد يُقال: إنّه (عليه السّلام) قُتل من أجل الإصلاح، لا من أجل البكاء والضجيج والنياح.
لكنّ ملاحظة وضع الناس في تعاملهم مع الأمر الواقع وتعايشهم معه، وخفّة وقع الأحداث في أنفسهم بمرور الزمن تشهد بأنّه لولا إصرار الشيعة على إحياء فاجعة الطفّ، وإبراز الجوانب العاطفية فيها التي تحمل على البكاء وتستدرّ الدمعة، وتثير العجيج والضجيج، لخفّ وقع الفاجعة بمرور الزمن، ولنسيها الناس كما نسوا كثيراً من الأحداث المهمّة؛ نتيجة طول المدّة.
وحينئذ لا يتسنّى الاستفادة من الفاجعة في استحصال العِبر، وإصلاح المجتمع وتنفيره من الظلم والظالمين، وتذكيره بالمبادئ السامية التي نهض الإمام الحسين (عليه السّلام) من أجلها، وضحّى هو وجميع أهل البيت (صلوات الله عليهم) في سبيلها، ولضاعت علينا الثمرات الكثيرة التي لازال التشيّع والشيعة تجنيها بإحياء فاجعة الطفّ، والانطلاق منها لإحياء جميع مناسبات أهل البيت (عليهم السّلام).
ولعلّ ذلك هو الوجه في التأكيد المكثّف من قِبَل الأئمّة (صلوات الله عليهم) على إحياء هذه المناسبات والتذكير بها، والتركيز على الجوانب العاطفية فيها، وعلى الصرخة واستدرار الدمعة.
وهم (عليهم السّلام) الأعرف بالأهداف السامية التي حملت الإمام الحسين (عليه السّلام) على نهضته المباركة، والإقدام على تلك التضحيات الجسيمة التي تمخّضت عنها، كما إنّهم (صلوات الله عليهم) الأعرف أيضاً باستثمارها لصالح الدين وأهله.
التأكيد على أهمّية الإمامة في الدين وبيان ضوابطها
الثالث : بيان أهمّية الإمامة في الدين وضوابطها وشروطها ووجوبها، وعدم خلوّ الأرض من الإمام، ورفعة مقام الإمام عند الله (عزّ وجلّ)، وتميّزه عن رعيته بالعلم والعصمة وكثير من صفات الكمال، ووجوب معرفته وموالاته وطاعته والتسليم له، وحرمة الردّ عليه والاستهانة بشأنه... إلى غير ذلك.
وما ورد عنهم (عليهم السّلام) في ذلك كثير جدّاً، وبمضامين في غاية السمو والرفعة، ولا يسعنا التعرّض لها إجمالاً، فضلاً عن تفصيل الكلام فيه، ويسهل الاطلاع عليها بالرجوع لتراثهم الرفيع.
دعم مقام الإمامة بالكرامات والمعاجز
وقد دعم ذلك وأكّده ما صدر منهم (عليهم أفضل الصلاة والسّلام) إماماً بعد إمام من الكرامات الباهرة، والمعاجز الخارقة التي تأخذ بالأعناق.
وقد بدأ ذلك أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)، وتتابع عليه الأئمّة من ولده (عليهم السّلام) حتى نشأ عليه الشيعة، وعُرف بينهم، فكان من دلائل الإمامة التي تتوقّع ممّنْ يتصدّى لها أو يدّعيها، وكثيراً ما يطالب بها.
وهذه المفاهيم والأمور كلّها غريبة على جمهور المسلمين حسبما نشأوا عليه من مفاهيم الإمامة وواقع أئمّتهم، حتى ربما كان الاعتقاد بذلك سبباً للتشهير بالشيعة والتشنيع عليهم.
وذلك ممّا يزيد الشيعة تمسّكاً وإصراراً، بل هو منشأ لاعتزازهم؛ لشعورهم بأنّهم يتميّزون بحقيقة شريفة، وواقع رفيع لا تتحمّله عقول غيرهم، والناس أعداء ما جهلوا.
اعتراف غير الشيعة بكرامات أهل البيت (عليهم السّلام)
وأخيراً تمّ فرض ذلك على أرض الواقع، واعترف به الكثير من غير الشيعة، بل حتى من غير المسلمين؛ فأخذوا يلجأون في مهمّاتهم ومشاكلهم حين تضيق بهم الأمور، وتنسدّ أمامهم الطرق الطبيعية إلى أئمّة أهل البيت (صلوات الله عليهم) وأبرار ذريّتهم، ويتوسّلون بهم؛ إمّا بزيارة قبورهم، أو بإحياء مناسباتهم، أو النذر لهم، أو غير ذلك.
فيرون ما يحبّون وينقلبون مسرورين بقضاء حوائجهم وتفريج كرباتهم، والحديث في ذلك طويل وشواهده كثيرة، وقد أشرنا لطرف من ذلك في آخر كتابنا (في رحاب العقيدة)، وتحدّث عنه الكثيرون، ولازلنا نعيشه.
التأكيد على شدّة جريمة خصوم أهل البيت (عليهم السّلام)
الرابع : التركيز في المقابل على شدّة جريمة أعداء أهل البيت وغاصبي حقوقهم وقتلتهم ومنتهكي حرماتهم، وعلى خبثهم وسوء منقلبهم وهلاكهم، وهلاك أتباعهم وأوليائهم، ثمّ وجوب معاداتهم والبراءة منهم مع التأكيد على ذلك بمختلف الوجوه، وتحرّي المناسبات المختلفة لبيانه والتذكير به.
التركيز على الارتباط بالله تعالى بمختلف الوجوه
الخامس : التركيز على الارتباط بالله (عزّ وجلّ)، وعلى تحرّي رضاه بلزوم طاعته وتجنّب معصيته، والإخلاص له، والرجاء لثوابه، والخوف من عقابه، وحسن الظنّ به، والتوكّل عليه، والتسليم له، والرضى بقضائه، والصبر على محنته وبلائه، واللجأ له، وطلب الحوائج منه... إلى غير ذلك من شؤون الارتباط به تعالى وتوثيق العلاقة معه.
وقد سبق أنّ ذلك كان معروفاً عن شيعة أهل البيت في الأجيال الأولى(١) ، وذلك ممّا يعين على تركيزه في الأجيال اللاحقة حيث يصير بمرور الزمن سمة شرف مميّزة للكيان الشيعي تحملهم على التحلّي به.
والأهم من ذلك أنّ الأئمّة من أهل البيت (صلوات الله عليهم) - الذين هم أئمّة الشيعة وقدوتهم - في المرتبة العليا من الدين والإخلاص والواقعية والفناء في ذات الله (عزّ وجلّ)، وفي التأكيد على الالتزام بأحكامه وتعاليمه والدعوة لذلك بسلوكهم الرفيع، وأحاديثهم الشريفة، ومواعظهم الشافية.
وقد سلك الأئمّة (صلوات الله عليهم) في التركيز على هذه الأمور الثلاثة - التي لها أعظم الأهمية من الناحيتين العقائدية والعملية - طريقين:
التركيز على الأمور المذكورة في أحاديثهم (عليهم السّلام)
أحدهما : بيان المضامين المذكورة وشرحها وتوضيحها في أحاديثهم الخاصة مع شيعتهم، كتراث محفوظ في الكتب يرجع إليه مَنْ يريد التعرّف على ثقافتهم (عليهم السّلام)، والاطلاع على تعاليمهم الشريفة، ويدعمه في ذلك كثير من التراث الثقافي والتاريخي لعموم المسلمين.
وقد أكثروا (عليهم السّلام) من ذلك على اختلاف أنحاء البيان في الإجمال والتفصيل حسب اختلاف المقامات والمناسبات، كما يشهد بذلك الرجوع إلى تراثهم القيم الذي حفظه وتوارثه علماء شيعتهم وحملة ثقافتهم جيلاً بعد جيل.
وبذلك تدعم الدعاوى العريضة التي يدعيها الشيعة في أهل البيت (صلوات الله عليهم) وفي خصومهم، وعليها يبتني التولّي والتبري والتديّن التي يظهر بوضوح في كيان الشيعة الثقافي والعملي.
____________________
١ - تقدّم في/٣٥٨.
التركيز على الأمور المتقدّمة في الأدعية والزيارات
ثانيهما: الأدعية والزيارات الكثيرة في المناسبات المختلفة، وقد كان لها الأهمية الكبرى في تركيز هذه الأمور:
أوّلاً : لِما تتميّز به من بيان فريد في الفصاحة والبلاغة، ورفعة المستوى، ورصانة الأسلوب، وقوّة العرض، وجمال الطرح مع علوّ المضمون وشرفه، وأصالته وارتكازيته.
ولذلك أعظم الأثر في أن تأخذ موقعها من القلوب، وتترك أثرها في النفوس؛ فتتقبلها وتتفاعل بها وتبخع لها.
وثانياً : لأنّ مَنْ يؤدّي وظيفة قراءتها ويقوم بهذا الشعار يتحوّل إلى عالم روحاني شريف، وجوّ عرفاني قدسي؛ حيث يخاطب الله (جلّ جلاله) بالدعاء، ويتضرّع بين يديه، ويخاطب رموزه المقدّسة بالزيارات في المناسبات الشريفة المختلفة، ويؤدّي فروض الاحترام والتبجيل له؛ وذلك أحرى بأن يُحمل على الإيمان بتلك المضامين، والتفاعل بها.
وثالثاً : لأنّ أداء تلك الوظائف والقيام بتلك الشعائر لا يختصّ بفئة خاصة دون فئة، كأهل العلم مثلاً دون غيرهم، بل يشترك فيه جميع الشيعة الموالين لأهل البيت (صلوات الله عليهم) على اختلاف طبقاتهم.
ولاسيما مع كثرة المناسبات المذكّرة بهذه الأمور، وتكرّرها على مدار السنة، بل قد يتكرّر بعضها في كلّ يوم - كالتعقيب للصلوات المفروضة - أو على مدار الأسبوع، أو الشهر.
مضافاً إلى أهمّية كثير من هذه المناسبات حتى صارت مواسم عامّة يجتمع فيها الحشود الكبيرة والجموع الغفيرة، وإلى كثرة مراقدهم (صلوات الله عليهم)
ومشاهدهم الشريفة، ومشاهد مَنْ يتعلّق بهم وينسب إليهم ممّنْ يقصده الشيعة بالزيارة، بالإضافة إلى بعض المساجد المعظمة التي يقصدها الشيعة ويؤدّون فيها مراسم العبودية لله (عزّ وجلّ).
وكان لذلك أعظم الأثر في تعميم هذه الثقافة في المجتمع الشيعي، وتركيزها على الصعيد العام بحيث صارت هذه الأمور من الملامح المميّزة للكيان الشيعي العام، والسمات الظاهرة فيه رغم كلّ المعوّقات والمثبّطات.
جامعية زيارة الجامعة الكبيرة وزيارة يوم الغدير
ويبدو أنّ الإمام أبا الحسن علي بن محمد الهادي (صلوات الله عليه) قد حاول أن يجمع ما ورد متفرّقاً عمّنْ قبله من آبائه (صلوات الله عليهم) - في بيان رفعة مقام أهل البيت، ووجوب موالاتهم، وبيان جريمة أعدائهم، ووجوب البراءة منهم - في الزيارتين المشهورتين؛ الزيارة الجامعة الكبيرة لجميع الأئمّة (صلوات الله عليهم)، وزيارة أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسّلام) يوم الغدير، وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجّة الحرام؛ حيث أعلن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند منصرفه من حجّة الوداع بالنصّ بالولاية من بعده لأمير المؤمنين (عليه السّلام).
فقد أفاضت هاتان الزيارتان في الأمرين الأخيرين بنحو يصلحان لأن يكونا بمجموعهما أطروحة كاملة عن الموقف العقائدي الشيعي من أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسّلام) ومن أعدائهم وخصومهم؛ ليكونا سبباً لتذكير عموم الشيعة بعقيدتهم وتركيزها في نفوسهم.
أمّا الأدعية الكبيرة والصغيرة - في مختلف أمور الدنيا والآخرة -، والأوراد والأذكار، والصلوات والأعمال فهي من الكثرة بحيث لا مجال لاستقصائها، ومن الظهور والاشتهار بحيث يسهل على كلّ أحد الوصول إليها والاطلاع عليها.
التأكيد على عدم شرعية الجور
السادس : التأكيد على عدم شرعية سلطة الجور، وتحريم السير في ركاب الجائر، وإعانته ودعمه، والركون إليه، ووجوب مباينته قلباً وعملاً، إلّا في حدود الضرورة، أو مصلحة المذهب الحقّ على ما يُذكر مفصلاً في كتب الفقه.
وإذا كان أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسلام) قد دعم حروب الفتح الإسلامي الأولى تحت لواء الخلفاء الأولين، من أجل تثبيت الكيان الإسلامي، وإسماع دعوة الإسلام، لتقوم بها الحجة على الأمم والشعوب المختلفة، فقد ارتفعت الحاجة لذلك في عهود الأئمة من ذرية الحسين (صلوات الله عليهم) بعد أن قام الكيان المذكور وفرض نفسه على أرض الواقع وظهرت دعوته.
ومن ثم منعوا عليهم السلام شيعتهم من الجهاد مع خلفاء الجور، وتحت لوائهم، إمعاناً في مباينتهم، وتأكيداً لعدم شرعية سلطتهم. واقتصروا في جواز الجهاد على الحروب الدفاعية، اهتماماً منهم عليهم السلام بالكيان الإسلامي العام وحفاظاً عليه.
وذلك بمجموعة يجعل التنفّر من الظالمين وإنكار شرعية سلطانهم، وعدم الركون إليهم والتفاعل معهم، حالة ثابتة في نفوس الشيعة، ومتركزة في أعماقهم حتى لو اضطروا لمجاراتهم عملاً.
إحياء تعاليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته وجميع المعارف الحقة
السابع: إحياء تعاليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآثاره وسيرته، وتاريخ ظهور الإسلام، ونشر ذلك خالياً من الشوائب والأوهام بعد أن حاولت السلطات التعتيم عليه، والتحريف له، وتشويهه حسب اختلاف المقامات.
وأعانها على ذلك الفتن المتلاحقة، والاضطراب السياسي الذي شغل عامّة المسلمين عن التعرّف على دينهم وتعاليمه الحقّة وتاريخه الصحيح.
وقد بلغ التحريف والتشويه فيها حدّاً مأساوياً قد ينتهي بالتنفير من الدين ورموزه، ويتخذ ذريعة للتشهير والتشنيع من قبل الأعداء والطامعين.
كما فتح الأئمّة (صلوات الله عليهم) أبواب المعارف الحقّة التي ورثهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفاتيحه؛ لأنّهم أبواب مدينة علمه.
فأظهروا كثيراً من الحقائق في العقائد، وبدء الكون والخليقة، وخواص الأشياء، وفي الآداب ومكارم الأخلاق، وسنن الأنبياء وسيرتهم، وغيرها من فنون المعرفة التي ميّزهم الله (عزّ وجلّ) بها عن غيرهم فضلاً منه عليهم.
وقد سبقهم إلى ذلك أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسّلام) الذي هو باب مدينة علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجرى على ذلك جميع الأئمّة من ولده (صلوات الله عليهم)؛ لأنّهم ورثوا علمه، إلّا إنّ الأئمّة من ذرية الحسين (صلوات الله عليهم) قد تفرّغوا لذلك كما سبق.
اهتمام الأئمّة (عليهم السّلام) بحملة آثارهم وعلماء شيعتهم
وقد حاولوا (صلوات الله عليهم) تثقيف شيعتهم بثقافتهم عن طريق أصحابهم وخواصهم من الرواة وحملة الآثار، وقد جعلوهم وسائط بينهم وبين شيعتهم؛ من أجل أن يرجعوا إليهم ويأخذوا عنهم معالم دينهم ومعارفه، ويستغنوا بهم عمّنْ سواهم.
وقد اشتدّ اهتمامهم (عليهم السّلام) بذلك حتى ورد في صحيح هشام بن سالم عن الإمام الصادق (صلوات الله عليه) أنّه قال: «لما حضرت أبي (عليه السّلام) الوفاة قال: يا جعفر، أوصيك بأصحابي خيراً. قلت: جعلت فداك، والله لأدعنهم والرجل
منهم يكون في المصر فلا يسأل أحداً»(١) .
وقد أكّدوا (عليهم أفضل الصلاة والسّلام) على الرجوع للعلماء والأخذ عنهم والقبول منهم في أحاديث كثيرة.
منها : حديث عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق (عليه السّلام) الوارد في تنازع الشيعة بينهم في الحقوق، وفيه: «انظروا إلى مَنْ كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً؛ فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً. فإذا حكم بحكمنا فلم يُقبل منه فإنّما بحكم الله استُخفّ، وعلينا رُدّ. والرادّ علينا رادّ على الله، وهو على حدّ الشرك بالله (عزّ وجلّ)...»(٢) .
ومنها: التوقيع الشريف عن الإمام المهدي المنتظر (عجّل الله تعالى فرجه الشريف)، وفيه: «فإنّه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤدّيه عنّا ثقاتنا؛ قد عرفوا أنّا نفاوضهم سرّنا، ونحمله(٣) إيّاه إليهم»(٤) .
ومنها : التوقيع الآخر عنه (عليه السّلام)، وفيه: «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا؛ فإنّهم حجّتي عليكم، وأنا حجّة الله...»(٥) ... إلى غير ذلك.
تأكيد الأئمّة (عليهم السّلام) على التفقّه في الدين وعلى إحياء أمرهم
كما أكّدوا (صلوات الله عليهم) على التفقّه في الدين، وعلى كتابة الكتب
____________________
١ - الكافي ١/٣٠٦.
٢ - تهذيب الأحكام ٦/٢١٨، واللفظ له، الكافي ١/٦٧، وج ٧/٤١٢، وسائل الشيعة ١/٢٣، وج ١٨/٩٩.
٣- هكذا ورد في كتاب اختيار معرفة الرجال، ولكن الوارد في وسائل الشيعة «ونحمّلهم إياه إليهم».
٤ - اختيار معرفة الرجال ٢/٨١٦، واللفظ له، وسائل الشيعة ١/٢٧، وج ١٨/١٠٨ - ١٠٩.
٥ - كمال الدين وتمام النعمة/٤٨٤، واللفظ له، الغيبة - للطوسي/٢٩١، الاحتجاج ٢/٢٨٣، وسائل الشيعة ١٨/١٠١.
وتدوين العلم، ومذاكرته وتدارسه وتعليمه، وعلى إحياء أمرهم (عليهم السّلام)، وأنّ به حياة قلوب شيعتهم.
وقد استطاعوا (صلوات الله عليهم) في المدّة الطويلة التي قضوها مع شيعتهم - رغم الضغوط الشديدة والصراع المرير - أن يبثّوا تعاليمهم السامية وثقافتهم الأصيلة في العقائد والفقه، والأخلاق والأدعية والزيارات والمواعظ والسلوك وغيرها حتى تبلورت.
قيام الحوزات العلمية الشيعية ومميّزاتها
وبذلك قام للشيعة كيان علمي وثقافي متميّز، حملته وحافظت عليه الحوزات العلمية في مختلف بقاع الأرض التي يتواجد فيها الشيعة.
وقد رعى الأئمّة (صلوات الله عليهم) هذه الحوزات مدّة تزيد على قرنين ونصف، ووضعوا الضوابط العامّة لها، وراقبوا مسيرتها حتى تأقلمت مع نهجهم (عليهم السّلام)، وحملت بصماتهم، وتفاعلت مع مفاهيمهم بحيث أمنوا عليها من الزيغ والانحراف.
ونتيجة لذلك تميّزت هذه الحوزات بالاهتمام بالبحث عن الحكم الشرعي، وأخذه من مصادره الأصيلة وحججه المعذّرة بين يدي الله تعالى، وبالحفاظ على حدوده وحرفيته، بعيداً عن التخرّص والتسامح، وعن التأثّر بالجهات الخارجية من سلطان أو عرف اجتماعي أو غير ذلك؛ جرياً على نهج أهل البيت (صلوات الله عليهم)، والتزاماً بتعاليمهم الموافقة للفطرة، وحكم العقل السليم.
تحديد الاجتهاد عند الشيعة
وذلك هو الاجتهاد الذي بقي مفتوحاً عند شيعة أهل البيت أعزّ الله
دعوتهم، واستمروا عليه هذه المدّة الطويلة، وليس الاجتهاد عندهم تطويع الحكم الشرعي لأوضاع المجتمع القائمة، وتطبيعه وتحويره بما يتناسب مع الظروف المختلفة، والمؤثّرات الطارئة.
وبذلك أمِن الأئمّة (عليهم أفضل الصلاة والسّلام) على تعاليمهم الشريفة، وثقافتهم السامية من الضياع والتحريف والتحوير.
ولهذا أمكن وقوع الغيبة الكبرى بانقطاع خاتم الأئمّة المهدي المنتظر (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) عن الاتصال المباشر بالشيعة؛ لاكتفاء الشيعة بما عندهم من تعاليم وثقافة دينية تقوم بها الحجّة عليهم، وعلى الناس من مختلف الفئات والأديان والمذاهب( لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ ) (١) .
وكأنّه إلى ذلك يشير حديث المفضّل بن عمر قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السّلام): «اكتب وبثّ علمك في إخوانك، فإنّ متّ فأورث كتبك بنيك؛ فإنّه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلّا بكتبهم»(٢) .
ظهور المرجعيات الدينية بضوابطها الشرعية
وقد انبثقت من تلك الحوزات - نتيجة الحاجة الملحّة، خصوصاً بعد الغيبة الكبرى - المرجعيات الدينية، بضوابطها الشرعية المعذّرة بين يدي الله (عزّ وجلّ).
وعمدة تلك الضوابط - بعد العلم بأحكام الدين - العدالة بمرتبة عالية تناسب ثقل الأمانة التي يعهد فيها للمرجع، وهي دين الله تعالى القويم؛ حيث يتعرّض المرجع لضغوط نفسية وخارجية كثيرة في عملية الوصول للحكم
____________________
١ - سورة الأنفال/٤٢.
٢ - الكافي ١/٥٢، كشف المحجّة لثمرة المهجة/٣٥، وسائل الشيعة ١٨/٥٦.
الشرعي، وفي الفتوى وتثقيف عموم المؤمنين به.
فلا بدّ من قوّة العدالة، تبعاً لشدّة الخوف من الله (عزّ وجلّ)؛ لتكون حاجزاً دون الانحراف أمام تلك الضغوط، ومانعاً من الاستجابة لها مهما اشتدّت.
بعض الأحاديث في ضوابط التقليد
وفي الحديث الشريف عن الإمام الصادق (عليه السّلام) أنّه بعد أن ذمّ اليهود بتقليدهم لعلمائهم قال: «وكذلك عوام أُمّتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر، والعصبية الشديدة، والتكالب على حطام الدنيا وحرامه، وإهلاك مَنْ يتعصّبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحق، وبالترفرف بالبر والإحسان على مَنْ تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحق، فمَنْ قلّد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء، فهم مثل اليهود الذين ذمّهم الله بالتقليد لفسقة فقهائهم.
فأمّا مَنْ كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه. وذلك لا يكون إلّا بعض فقهاء الشيعة، لا جميعهم؛ فإنّه مَنْ ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامّة، فلا تقبلوا منّا عنه [منهم عن. وسائل] شيء، ولا كرامة...»(١) .
وكان نتيجة ذلك أمور:
ارتباط الشيعة بمرجعياتهم الدينية عملياً وعاطفياً
أوّلها : ارتباط الشيعة بمرجعياتهم الدينية عملاً؛ لحاجتهم لهم بسبب شمولية التشريع الإسلامي لجميع شؤون الإنسان ومفردات حياته.
ثانيها : ارتباطهم بمرجعياتهم المذكورة عاطفياً ولاءً واحترام؛ بسبب
____________________
١ - الاحتجاج ٢/٢٦٤، واللفظ له، وسائل الشيعة ١٨/٩٥.
اعتقادهم بتدينها، بحيث تكون أهلاً لائتمانهم لها على دينهم، فكأنّها واجهة لأئمّتهم (صلوات الله عليهم)، وممّثلة لهم (عليهم السّلام).
ولاسيما مع شعور هذه المرجعيات بمسؤوليتها إزاء المؤمنين في إصلاح أمرهم، وتوحيد كلمتهم، وعلاج مشاكلهم، وتخفيف أزماتهم ومواساتهم، ومدّ يد العون لهم حيث أوجب ذلك الشعور المتبادل بأبوة المرجعية الدينية، وتوثّق الروابط بينها وبين المؤمنين.
ثالثها : إنّ للثقافة الدينية والحكمة والتقوى والإخلاص والاهتمام بصلاح الدين والمؤمنين أعظم الأثر في تقريب وجهات النظر بين مراجع الدين في أداء وظيفتهم، وتخفيف حدّة الخلاف بينهم بنحو يؤدّي إلى موقف موحّد أو شبه موحّد في توحيد الشيعة ومعالجة مشاكلهم بالرغم من فتح باب الاجتهاد، وتمتّع الجميع بالحرية في اختيار المواقف المناسبة.
قيادة المرجعية للأُمّة
وبذلك استطاعت المرجعية الشيعية قيادة الأُمّة وتوحيدها في عصر الغيبة الطويل؛ حيث لا إمام ناطق تجب طاعته، ولا يتمتّع المرجع - واحداً كان أو أكثر - بقوّة مادية قاهرة ترغم على متابعته.
نعم، لا ريب في أنّ للتسديد الإلهي أعظم العون على ذلك، مشفوعاً برعاية إمام العصر والزمان (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) الذي يكون الانتفاع به في غيبته كالانتفاع بالشمس إذا جلّلها السحاب.
العمق التاريخي للمرجعية
ومن الملفت للنظر أن هذه المؤسسة بقيت ما يقرب من أربعة عشر قرناً
مستمرة في فاعليتها وعطائها، محافظة على وظيفتها وأهدافها واستقامتها. رغم كل المعوقات والمثبطات الداخلية والخارجية التي تعرضت لها في تاريخها الطويل. وهي حالة فريدة من بين المؤسسات الأخرى الدينية وغيرها.
ويزيد في العجب أنها في مدة أحد عشر قرناً من مبدأ الغيبة الكبرى تفقد القوة الملزمة مادياً أو دينياً، بل تعتمد على القناعة الشخصية من المرجع والأتباع بأداء الواجب والقيام بالوظيفة الشرعية، مع ما هو المعلوم من تعرض وجهات النظر للاختلاف.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدّد المرجعيات ويمدّها - ببركة إمام العصر (صلوات الله عليه) - بالتوفيق للثبات على السير في الطريق المستقيم، ويوفّق المؤمنين للتجاوب معها والتلاحم من أجل أداء الوظيفة، والخروج عن التكليف الشرعي. إنّه المسدّد للحسنات، والعاصم عن السيئات، والناصر للمؤمنين، وهو حسبنا ونِعْمَ الوكيل.
تأكيد الأئمّة (عليهم السّلام) على حقّهم في الخمس
الثامن : إنّه بعد أن تركّز التشيّع لأهل البيت (صلوات الله عليهم) كعقيدة راسخة تحملها جماعة لها كيانها الخاص بها؛ بدأ الأئمّة من ذرية الحسين (عليه السّلام) بتذكير شيعتهم بحقّهم في الخمس، ذلك الحقّ الذي كاد يُنسى نتيجة مواقف الأوّلين من أهل البيت (عليهم السّلام)، وخطواتهم المتلاحقة من أجل تغييبهم (عليهم السّلام) عن ذاكرة المسلمين.
وبعد أن ذكّروا (صلوات الله عليهم) شيعتهم بهذا الحقّ بدأوا بمطالبتهم بأدائه، والتأكيد على ذلك تدريجاً؛ ليكون للشيعة - كمذهب وأفراد - مورداً مالياً يعينهم في إدارة شؤونهم وسدّ حاجاتهم بعد أن حُرموا من الأموال العامّة التي
هي تحت سيطرة الدولة.
وهذا المورد وإن كان قليلاً لا يفي بالحاجة؛ لتهاون كثير من ذوي المال في أدائه، إلّا إنّه صار نواة لتُضاف إليه بقيّة الحقوق الشرعية والخيرات والمبرات والأوقاف وما جرى مجرى ذلك.
استقلال التشيّع مادياً
كما إنّه وجّه الشيعة تدريجاً نحو الاعتماد على النفس، والتكافل في الجملة، والقناعة بالقليل، وتحمل شظف العيش نسبياً.
وقد سبق التنبيه لكثرة الأموال التي ينفقها الشيعة طوعاً، بل عن رغبة وإصرار؛ من أجل إحياء ذكرى فاجعة الطفّ وغيرها من مناسبات أهل البيت (صلوات الله عليهم)(١) .
وكذلك هو الحال فيما ينفقونه في سبيل التبليغ الديني؛ من أجل قيام الحوزات التي ترعاها وتنبثق منها المرجعيات الدينية، أو من أجل التبليغ في البلاد المتفرّقة، أو في طبع الكتب ونشر الثقافة الدينية... إلى غير ذلك.
استقلال الحوزات والمرجعية الدينية عن السلطة
وكان من نتائجه المهمّة شرف استقلال الحوزات والمرجعيات الدينية عن السلطة وغيرها من الجهات المتموّلة، وعدم الانصهار بها، أو التبعية لها، والتأثّر بتوجّهاتها.
وبذلك حافظت الحوزات والمرجعيات على بهائها وقدسيتها في واقعه، وفي نفوس المؤمنين، وفرضت احترامها حتى على غيرهم، وكان لها الدور الفعّال
____________________
١ - راجع/٤٢٧.
في الحفاظ على الكيان الشيعي بحدوده العقائدية، وأحكامه الفقهية العملية، ومميّزاته المشار إليها آنفاً وإن كلّفها ذلك كثيراً من المتاعب والمصائب.
تميّز الكيان الشيعي
وكانت حصيلة جميع ما سبق قيام كيان للشيعة متميّز في العقائد والفقه، والعلاقة بالله (عزّ وجلّ) والأدعية والزيارات، وجهات الثقافة الأُخرى، وفي الكيان الحوزوي والمرجعي، وفي التوجّهات والإصرار، والسلوك والممارسات.
وقد دعم هذا الكيان المتميّز أمور أربعة لها أهمّيتها القصوى:
الأوّل : قوّة حجّته وتناسق دعوته، ومطابقتها للفطرة من دون تناقضات، ولا سلبيات، ولا مفارقات كما ذكرناه آنفاً.
وهو رصيد ضخم للدعوة تستفيد منه حين ينبّه هذا الكيان - بممارساته التبليغية والعاطفية - الغافلين؛ حيث قد يحملهم على البحث الموضوعي عن الحقّ، بعيداً عن التعصّب والتراكمات فيستفيدون من هذا الرصيد، ويستجيبون لدعوته الشريفة.
الثاني : رفعة مقام الأئمّة (صلوات الله عليهم)، وفرض احترامهم على عموم المسلمين؛ حيث يزيد ذلك الشيعة اعتزازاً بالانتساب إليهم والتمسّك بهم (عليهم السّلام)، وقوّة في الدعوة لحقّهم (عليهم السّلام)، وجاذبية للغير نحوها تحملهم على الاستجابة له.
الثالث : الاعتقاد بوجود الإمام المنتظر الذي يرعى الدعوة وحملتها، ويكون الانتفاع به في غيبته كالانتفاع بالشمس إذا جلّلها السحاب. حيث يبعث ذلك الأمل في نفوس الشيعة باستمرار، ويبعد عنهم الاحباط نسبياً في أزماتهم
ومحنهم ومصائبهم التي قد تبلغ حدّ الكوارث.
الرابع : المدّ الإلهي غير المحدود، والكرامات الباهرة، والمعاجز القاهرة التي تأخذ بالأعناق؛ حيث يعطي ذلك حيوية ودفعاً للدعوة باستمرار.
فرض الكيان الشيعي على أرض الواقع
وكانت نتيجة ذلك كلّه أن فرض هذا الكيان المتميّز نفسه على أرض الواقع - رغم المعوّقات الكثيرة، والصراع المرير على طول التاريخ حتى يومنا الحاضر - من دون أن يعتمد على سلطة ينسّق معها وتدعمه، وإن كان قد يستفيد من السلطة في بعض الفترات من دون أن يكون تابعاً لها منصهراً بها، أو تتحكّم فيه وفي توجهاته.
وقد حصل ذلك بفضل جهود الأئمّة من ذرية الإمام الحسين (صلوات الله عليهم) بعد أن أصحروا بإعراضهم عن السلطة، وتفرّغوا لشيعتهم؛ ليكملوا الشوط، ويستثمروا المكاسب العظيمة التي حقّقها الأئمّة الأوّلون (صلوات الله عليهم) والخاصة من شيعتهم في سلوكهم الحكيم، وتضحياتهم الجسيمة.
تحقيق الوعد الإلهي ببقاء جماعة تلتزم الحقّ وتدعو له
كلّ ذلك من أجل قيام طائفة في الأُمّة ظاهرة، تنطق بالحق، وتعمل به، وتدعو له، وتكبح جماح الانحراف، وتنكر عليه.
تحقيقاً للوعد الإلهي الذي يشير إليه قوله (عزّ وجلّ) في محكم كتابه المجيد:( وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ) (١) .
وقوله تعالى:( وَإِن تَتَوَلَّوْا
____________________
١ - سورة الأعراف/١٨١.
يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثمّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ) (١) ، وقوله سبحانه:( يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ) (٢) .
وهو صريح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: «لا تزال طائفة من أُمّتي ظاهرين على الحقّ، لا يضرّهم مَنْ خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك»(٣) .
وحديث سليمان بن هارون عن الإمام الصادق (صلوات الله عليه) الذي يردّ فيه على بعض الدعوات المنحرفة عن خطّ الإمامية حيث قال (عليه السّلام) عن سيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم منكراً دعواهم: «وإنّ صاحبه لمحفوظ محفوظ له. ولا يذهبن يميناً ولا شمالاً؛ فإنّ الأمر واضح. والله لو أنّ أهل الأرض اجتمعوا على أن يحوّلوا هذا الأمر من موضعه الذي وضعه الله ما استطاعوا. ولو أنّ خلق الله كلّهم جميعاً كفروا حتى لا يبقى أحد جاء الله لهذا الأمر بأهل يكونون هم أهله»(٤) ... إلى غير ذلك ممّا ورد في الكتاب المجيد وعن النبي وأهل البيت (صلوات الله عليهم أجمعين).
كلّ ذلك لإلفات نظر الناس وتنبيههم، وإقامة الحجّة عليهم؛ ليبحثوا عن الحقّ، وينظروا في أدلّته الظاهرة وحججه القاهرة، ولا يقولوا:( إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ) (٥) .
____________________
١ - سورة محمد/٣٨.
٢ - سورة التوبة/٣٢.
٣ - صحيح مسلم ٦/٥٢ - ٥٣، واللفظ له، كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أُمّتي ظاهرين على الحقّ لا يضرّهم مَنْ خالفهم، صحيح البخاري ٨/١٤٩ كتاب الاعتصام بالكتاب والسُنّة، صحيح ابن حبان ١/٢٦١ كتاب العلم، ذكر إثبات النصرة لأصحاب الحديث إلى قيام الساعة، ١٥/٢٤٨ كتاب التاريخ، باب إخباره صلى الله عليه وآله وسلم عمّا يكون في أُمّته من الفتن والحوادث، ذكر البيان بأنّ الفتن إذا وقعت والآيات إذا ظهرت كان في خللها طائفة على الحقّ أبداً، وغيرها من المصادر الكثيرة جدّاً.
٤ - بحار الأنوار ٢٦/٢٠٤.
٥ - سورة الأعراف/١٧٢.
تميّز دين الإسلام الحقّ ببقاء دعوته وظهور حجّته
وبذلك تميّز دين الإسلام الحقّ عن بقيّة الأديان حيث ظهرت حجّته، ولم تنطمس معالمه مع طول المدّة، وتعاقب الفتن، وتكالب الأعداء عليه من الداخل والخارج.
وقد سبق في حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهاره، لا يزيغ عنها بعدي إلّا هالك»(١) .
كلّ ذلك لأنّ الإسلام هو الدين الخاتم للأديان، والباقي ما بقيت الدنيا؛ فيجب أن تبقى معالمه واضحة، ودعوته مسموعة، وحجّته معه ظاهرة.
المقارنة بين فترة ما بين المسيح والإسلام ومدّة الغيبة
وذلك هو المبرّر المنطقي والتفسير الطبيعي لطول عصر غيبة الإمام المهدي المنتظر (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) مع شدّة الفتن، وتظاهر الزمن، وتكالب الأعداء، وعنف الصراع وشراسته.
بينما كانت المدّة بين رفع النبي عيسى (على نبينا وآله وعليه الصلاة والسّلام) وبعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا تتجاوز الستة قرون، وقد ضاعت فيها معالم الدين الحقّ الذي جاء به عيسى (عليه السّلام)، وانطمست أعلامه، وانفردت بالساحة دعوة الانحراف والتحريف.
وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى:( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَاءنَا مِن بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللهُ عَلَى كلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) (٢) .
____________________
١ - تقدّمت مصادره في/١٥٢.
٢ - سورة المائدة/١٩.
وعن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) أنّه قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «بعثه حين لا علم قائم، ولا منار ساطع، ولا منهج واضح»(١) .
وقال (عليه السّلام): «أرسله بالدين المشهور، والعلم المأثور...، والناس في فتن انجذم فيها حبل الدين، وتزعزعت سواري اليقين...، فالهدى خامل، والعمى شامل؛ عُصي الرحمن، ونُصر الشيطان، وخُذل الإيمان، فانهارت دعائمه، وتنكرّت معالمه، ودُرست سبله، وعفت شركه...»(٢) .
وقال (عليه السّلام): «إلى أن بعث الله سبحانه محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإنجاز عدته وتمام نبوّته...، وأهل الأرض يومئذ ملل متفرّقة، وأهواء منتشرة، وطوائف متشتتة؛ بين مشبّه لله بخلقه، أو ملحد في اسمه، أو مشير إلى غيره...»(٣) ... إلى غير ذلك.
بينما قال (صلوات الله عليه) عن عصر الغيبة الذي نحن فيه: «اللّهمّ إنّه لا بدّ لك من حجج في أرضك، حجّة بعد حجّة على خلقك؛ يهدونهم إلى دينك، ويعلّمونهم علمك؛ كيلا يتفرّق أتباع أوليائك. ظاهر غير مطاع، أو مكتتم يترّقب. إن غاب عن الناس شخصهم في حال هدنتهم فلم يغب عنهم قديم مبثوث علمهم، وآدابهم في قلوب المؤمنين مثبتة، فهم بها عاملون»(٤) .
وفي حديث المفضل بن عمر عن الإمام الصادق (عليه السّلام) قال: «أقرب ما يكون العباد من الله (جلّ ذكره)، وأرضى ما يكون عنهم إذا افتقدوا حجّة الله (عزّ جلّ) ولم يظهر لهم ولم يعلموا مكانه، وهم في ذلك يعلمون أنّه لم تبطل حجّة الله
____________________
١ - نهج البلاغة ٢/١٧٠.
٢ - نهج البلاغة ١/٢٨ - ٢٩.
٣ - نهج البلاغة ١/٢٤ - ٢٥.
٤ - الكافي ١/٣٣٩، واللفظ له، الغيبة - للنعماني/١٣٧.
جلّ ذكره، ولا ميثاقه...، وقد علم أنّ أولياءه لا يرتابون، ولو علم أنّهم يرتابون ما غيّب حجّته عنهم طرفة عين...»(١) .
وفي حديثه الآخر: كنت عند أبي عبد الله (عليه السّلام) وعنده في البيت أناس، فظننت أنّه إنّما أراد بذلك غيري، فقال: «أما والله ليغيبنَّ عنكم صاحب هذا الأمر، وليخملنَّ هذا حتى يُقال: مات؟ هلك؟ في أيّ وادٍ سلك؟ ولتُكفأن كما تُكفأ السفينة في أمواج البحر، لا ينجو إلّا مَنْ أخذ الله ميثاقه، وكتب الإيمان في قلبه، وأيّده بروح منه، ولترفعنّ اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدري أيّ من أيّ». قال: فبكيت. فقال: «ما يبكيك يا أبا عبد الله؟». فقلت: جعلت فداك، كيف لا أبكي وأنت تقول: اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدري أيّ من أيّ؟! قال وفي مجلسه كوّة تدخل فيها الشمس. فقال: «أبيّنة هذه؟». فقلت: نعم. قال: «أمرنا أبين من هذه الشمس»(٢) . وقريب منه حديثه الآخر(٣) .
حيث يظهر من هذه النصوص وغيرها ظهور دعوة الحقّ في عصر الغيبة، ووضوح حجّته، وثبات أهل التوفيق وذوي السعادة عليه رغم طول المدّة، وشدّة المحنة، واختلاف الآراء والاجتهادات، وكثرة الشبهات والضلالات والفتن والأهواء.
وهو ما حصل حتى الآن في دعوة التشيّع لأهل البيت (صلوات الله عليهم) رفع الله (عزّ وجلّ) شأنها وأعلى كلمتها.
وكلّما تأخّر الزمن زادت ظهوراً وانتشاراً، وفرضت نفسها على أرض الواقع، وكسبت تعاطف الناس وإعجابهم واحترامهم.
____________________
١ - الكافي ١/٣٣٣، واللفظ له، الغيبة - للنعماني/١٦٥.
٢ - الكافي ١/٣٣٨ - ٣٣٩.
٣ - الكافي ١/٣٣٦.
بل كثيراً ما اهتدى لنورها ودخل في حوزتها، واستظلّ برايتها مَنْ كتب الله (عزّ وجلّ) له التوفيق والسعادة، ولله أمر هو بالغه، وإليه يرجع الأمر كلّه.
ومن جميع ما سبق يظهر أنّ الأئمّة من ذرية الإمام الحسين (صلوات الله عليهم) قد أتمّوا ما بدأه الأئمّة الأوّلون (عليهم أفضل الصلاة والسّلام) من كبح جماح الانحراف الذي حصل، والعمل لإقامة الحجّة على الدين الحقّ، والمنع من ضياعه على الناس، وانطماس أعلامه وبيناته( لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ ) (١) .
فجزاهم الله تعالى جميعاً عن دينه وأهل دينه أفضل جزاء المحسنين، وثبّتنا على ولايتهم، وربط على قلوبنا، وزادنا بصيرة في أمرنا، ويقيناً في ديننا، وتسليماً لربّنا، إنّه أرحم الراحمين، وولي المؤمنين، وهو حسبنا ونِعْمَ الوكيل.
____________________
١ - سورة الأنفال/٤٢.
الخاتمة
يحسن الحديث فيها حول أمرين يتعلّقان بفاجعة الطفّ وما استتبعته من إيضاح معالم دين الإسلام ووضوح حجّته.
الأوّل: أثر ذلك في تعديل مسار الفكر الديني والإنساني عامّة، وإيضاح الضوابط التي ينبغي أن ينهجها طالب الحقيقة.
الثاني: في أهمّية إحياء الفاجعة، والسعي لتجديدها والتذكير بها، وآليّة ذلك.
وذلك يكون في فصلين:
الفصل الأوّل
في أثر وضوح معالم الإسلام في استقامة
منهج الفكر الإنساني
لا يخفى أنّ كبح جماح انحراف السلطة، والحيلولة دون تحكّمها في الدين، وقيام الحجّة على الدين الحقّ ووضوح معالمه، ونشاط فرقة الإمامية الاثني عشرية المؤكّدة على إمامة أهل البيت (صلوات الله عليهم)، والمتبنّية لثقافتهم الرفيعة، وتعاليمهم المنطقية الموافقة للفطرة السليمة، والمنكرة للظلم والطغيان، وتشويه الحقائق، وتحريف مفاهيم الدين الحنيف؛ نتيجة العوامل المتقدّمة، كلّ ذلك وإن كان بالدرجة الأولى فتحاً مبيناً لدين الإسلام العظيم ورموزه الشامخة،
إلاّ إنّه في الوقت نفسه نصر للأديان السماوية عامّة، ولرموزها المقدّسة.
دافعت ثقافة الإسلام الحقّ عن الأديان السابقة ونبهت لتحريفه
حيث نبّهت هذه التعاليم الموافقة للفطرة السليمة على تحريف تلك الأديان وتشويه صورة رموزها بفعل الظالمين، وإنّ تلك الأديان - في الحقيقة - منزّهة عمّا نسبته لها يد التحريف من مفاهيم وتعاليم متناقضة أو خرافية أو تافهة أو جائرة؛ لتكون آلة بيد المؤسسات السلطوية والمافيات الإجرامية؛ لتقوية نفوذها وتعزيز مواقعها، ولا يصل إلى جمهور الناس منها إلّا طقوس جوفاء لا تسمن ولا تغني من جوع.
وإنّ تلك الأديان في حقيقتها تحمل مفاهيم سليمة، وتعاليم سامية مطابقة للحكمة والفطرة؛ من أجل إصلاح البشرية عامّة، وتنظيم علاقتها فيما بينها على أفضل وجه، وتقريبها من الله (عزّ وجلّ)، وهدايتها إلى الصراط المستقيم.
تنزيه رموز تلك الأديان عمّا نسبته لهم يد التحريف
كما إنّ رموزها العظام (عليهم السّلام) في غاية الرفعة والجلالة والقدسية والكرامة على الله تعالى، والفناء في ذاته والقرب منه (جلّ شأنه)، وهم معصومون من الزلل، مطهّرون من الرجس.
وإنّهم (عليهم السّلام) قد جدّوا واجتهدوا في أداء رسالاتهم والتبليغ بها، والنصح لأممهم، وحملهم على الطريق الواضح من دون أن تأخذهم في الله لومة لائم.
وهم أيضاً منزّهون عمّا نسبته لهم يد التحريف الظالمة من الرذائل والموبقات ممّا يندى له الجبين، وتأباه كرامة الإنسان، ويهوي به إلى الحضيض.
وببيان آخر: الضوابط والتعاليم العامّة في دين الإسلام العظيم التي
يتبّناها القرآن المجيد، والسُنّة الشريفة، والثقافة المتميّزة لأهل البيت (صلوات الله عليهم) لا تبتني على الاختصاص بالإسلام، بل على العموم لجميع الأديان السماوية؛ سواء التي وصلت بقاياها لنا، أم التي لم تصل.
لاشتراكها جميعاً في كونها مشرّعة من قبل الله (عزّ وجلّ)، وهو الحكيم المطلق، المحيط بكلّ شيء، ولا يعزب عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء، والرؤوف بعباده الرحيم بهم، والعالم بما يصلحهم.
ولازم ذلك:
أوّلاً : أن لا يشرّع لهم من الدين إلّا ما يصلح شأنهم ويقرّبهم منه (عزّ وجلّ).
وثانياً : أن لا يأتمن على دينه وعباده إلّا مَنْ هو أهل لهذه الأمانة العظمى في علمه وورعه وعمله؛ ليعرّفهم بدينه، ويبلغهم به، ويحملهم عليه بقوله وسيرته، ويكون قدوة لهم يهتدون بهداه، ويستضيئون بنوره.
وكلّ ما خرج عن ذلك ممّا نُسب لتلك الأديان ورموزها المقدّسة لا بدّ أن يكون بهتاناً وزوراً، وتشويهاً ظالماً حتى لو صدرت نسبة ذلك ممّنْ ينتسب لتلك الأديان ويُعدّ من أتباعها.
كما إنّه ورد عن النبي وآله (صلوات الله عليهم أجمعين) الكثير من مفردات ذلك، وبيان تعاليم تلك الأديان التي تعالج مشاكل البشرية، والتأكيد على رفعة مقام رموزها العظام ونزاهتهم، وجهادهم في سبيل أداء رسالتهم، وما نالهم من الظلم والعدوان من أعداء دعوتهم ومن أممهم.
ولأجل ذلك فالحفاظ على الثقافة الإسلامية الأصيلة - نتيجة العوامل السابقة - كما يكون نصراً للإسلام العظيم يكون انتصاراً لتلك الأديان الشريفة ودفاعاً عنها، وحفاظاً على كرامتها وكرامة رموزها وقدسيتهم.
تحريف الأديان بنحو مهين
ومن الملفت للنظر أنّه قد حصل بسبب تحريف تلك الأديان من التعدّي على مقام الله (عزّ وجلّ)، وعلى الوسائط بينه وبين خلقه - من الرسل والأوصياء (صلوات الله عليهم) - وعلى تشريعاته القويمة ما ترفضه العقول وتأباه النفوس بفطرته، بل يندى له الجبين وتقشعرّ لهوله الأبدان.
إلاّ إنّ ذلك وحده لا يكفي في وضوح بطلان ذلك وتكذيبه، وظهور الحقيقة، وتنزيه تلك الأديان إذا لم تكن هناك ثقافة سليمة متكاملة ذات قواعد وأصول محكمة متينة، وكان لتلك الثقافة دعوة مسموعة يلجأ إليها طالب الحقيقة.
وبدون ذلك يبقى الإنسان الذي يحترم نفسه، ويعتزّ بعقله، ويستضيء به مذبذباً بين الدعاوى المتناقضة للأديان المختلفة غير الخالية في نفسها عن السلبيات المذكورة حتى قد يرفضها جميعاً ويكفر بها، ويلجأ للثقافة المادية الصرفة، أو يعتنق بعض تلك الأديان بمجرد الانتساب تقليداً للآباء من دون إيمان حقيقي متركز في أعماق النفس ودخائله.
لو تمّ تحريف الإسلام لضاعت معالم الحقّ على البشرية
ونتيجة لذلك فلو فُتح المجال لتحريف الإسلام الخاتم للأديان، ولم يكبح جماحه؛ نتيجة العوامل المتقدّمة، لضاعت المعالم ولم يبقَ بيد الناس حقيقة مقدّسة تقبلها العقول، وتركن إليها النفوس، وتأخذ بمجامع القلوب، وتتفاعل بها من أجل خيرها وصلاحها.
ولبقي المجتمع الإنساني في حيرة وضياع بين الثقافات الدينية المحرّفة - المملوءة بالأساطير والخرافات والسلبيات، التي تأباها النفوس وترفضها العقول، كما سبق - والثقافة المادية الجافة التي تأباها الفطرة السليمة، والتي
تسير بالمجتمع نحو الدمار الشامل في الأخلاق والمثل.
وحتى في مقوّمات نمو المجتمع الإنساني وبقائه في المعمورة؛ لاهتمام الثقافة المادية بحرية الفرد، وفسحها المجال لتمتّعه باللذة من أقرب طرقها من دون تركيز على بناء المجتمع، وتنظيم علاقة بعضه ببعض على أسس رصينة.
وقد كان لكبح جماح التحريف في الإسلام، وظهور دعوة الحقّ فيه أعظم الأثر في وضوح كثير من الحقائق في حق الله (عزّ وجلّ) وحق ملائكته وأنبيائه (صلوات الله عليهم) وتشريعاته القويمة، وظهور تشويهها في الأديان الأخرى، وحتى في بعض تراث المسلمين المشوّه.
ومن هنا كان لفاجعة الطفّ وغيرها من خطوات أهل البيت (عليهم السّلام) السابقة وجهودهم التي حدّت من محاولات التحريف لدين الإسلام العظيم، الفضل على الفكر الإنساني عامّة في وضوح منهجه وتعديل مساره.
ظهور السلبيات التي أفرزها التحريف
ويتضح ذلك بملاحظة أمر له أهميته، وهو أنّ الغرض المباشر من إقحام التراث المشوّه في الأديان - بما في ذلك دين الإسلام العظيم - هو تقبّل أتباعها له وإيمانهم به، وهو لا يكون إلّا لوجود الأرضية الصالحة لذلك بسبب اختلاط الأمر على الناس، وعدم وضوح معالم الحقّ من الباطل لهم. فوجود التراث المذكور في الأديان يكشف عن تحقّق تلك الأرضية حين إقحامه.
ولو أنّ الإسلام جرى على سنن الأديان السابقة، وتمّ للخطّ المخالف لأهل البيت (صلوات الله عليهم) ما أرادوا، ولم يكبح جماح الانحراف والتحريف نتيجة ما سبق، لبقيت هذه الأرضية ولتقبّل أهل كلّ دين تراثهم على ما هو عليه من التشويه، ولم يتوجهوا للسلبيات؛ لتشابه الأديان في ذلك
كواقع قائم، ولبقي الأمر مختلطاً على الناس.
بينما نرى الآن أنّ ما يحمله التشوّه - من خرافات أو ظلم للحقيقة لا يتناسب مع حقيّة تلك الأديان، أو تنافي كمال الله (عزّ وجلّ) المشرع له، أو قدسية الوسائط بينه وبين خلقه من الأنبياء والأوصياء (صلوات الله عليهم) - قد صار سمة عار على تلك الأديان وعلى المنتسبين إليه.
بحيث يكون مثاراً للنقد، بل الهجوم من طرف الخصوم، وسبباً لإحراج المنتسبين لتلك الأديان حتى قد يضطرون لتأويلها والخروج عن ظاهرها إن وجدوا لذلك سبيلاً، أو للفّ والدوران، وإشغال الخصوم بأمور جانبية تهرّباً من الجواب.
وربما يتهرّبون من فتح باب الحوار، أو يغلقونه بعد فتحه؛ لشعورهم بالعجز عن الدفاع والاستمرار في حلبة الجدال والصراع.
بل كثيراً ما يحاول حملة تلك الأديان والمعنيون بها صرف أتباع دينهم عن النظر في تراثه والاطلاع عليه والتدبّر فيه، أو منعهم عن فتح باب الحوار مع الآخرين والاطلاع على تراثهم والتعرّف على وجهة نظرهم، حذراً من أن يُصاب أتباع ذلك الدين بصدمة تزعزع عقيدتهم، وتجعلهم يبحثون عن البديل له.
وذلك يكشف عن اهتزاز تلك الأرضية، وأنّ معالم الحقّ والباطل أخذت موقعها المناسب من مرتكزات الناس، وصارت من الوضوح بحيث يتسالم عليها الكلّ، وقامت الثوابت التي يرجع إليها في مقام البحث والاستدلال.
كلّ ذلك بسبب كبح جماح الانحراف في الإسلام نتيجة الجهود المتقدّمة. ولا أقلّ من أنّ لذلك تأثيره المهم من هذه الجهة.
ولا نعني بذلك أنّ الناس قد اهتدت للدين الحقّ، ورفضت الأديان المحرّفة؛ إذ لازالت الحواجز عن ذلك قائمة من تقليد، أو تعصّب أو مصالح
مادية، أو عدم الاهتمام بمعرفة الحقيقة... إلى غير ذلك من العوامل.
بل كلّ ما حصل هو وضوح معالم الحقّ بحيث جعل أهل الأديان المحرّفة يدركون سلبيات أديانهم، ويضيقون به على خلاف ما كان عليه أسلافهم.
أمّا الاهتداء للدين الحقّ فيبقى منوطاً بأسبابه، وأهمّها النظرة الموضوعية في الأدلّة والحجج، والشجاعة في تخطّي الحواجز، والاهتمام بالوصول للحقيقة، مع التوفيق والتسديد الإلهي. و( الْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللهُ لَقَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ) (١) .
____________________
١ - سورة الأعراف/٤٣.
الفصل الثاني
في إحياء فاجعة الطفّ
قد تبيّن في غير موضع ممّا سبق أهمية إحياء فاجعة الطفّ، وجميع مناسبات أهل البيت (صلوات الله عليهم) بمختلف الوجوه؛ من زيارة مراقدهم الشريفة، وتعاهد مشاهدهم الكريمة وعمارتها، وإقامة المجالس المذكرة في مناسبات أحزانهم وأفراحهم، والقيام بمظاهر الحزن والأسى، أو مظاهر الفرح والسرور بالنحو الذي يتناسب مع الحدث، وقول الشعر فيهم (عليهم السّلام)... إلى غير ذلك.
ولاسيما مع تأكيد الأئمّة (صلوات الله عليهم) على ذلك بوجه مذهل لا يدع مجالاً لقائل، ولا عذراً لمعتذر كما يظهر بالرجوع لتراثهم الرفيع.
والذي يهمّنا هنا هو التنبيه لأمور تتعلّق بإحياء هذه المناسبات كنّا قد تعرّضنا لها في مناسبات مختلفة بنحو متفرّق، ويحسن بنا هنا جمعها، وربما أضفنا هنا ما لم نتعرّض له سابقاً.
اختلاف الناس في مظاهر التعبير عن شعورهم إزاء الأحداث
الأمر الأوّل: إنّ الناس تختلف في مظاهر تعبيرها عن عواطفها نحو الأحداث المتعلّقة بأهل البيت (صلوات الله عليهم)، ومناسبات أفراحهم وأحزانهم، فلكلّ فئة من الناس مظهر وطريقة في التعبير تتناسب مع مداركها وأحاسيسها وبيئاتها وخصوصياتها المزاجية، ولو حملت على طريقة أخرى لم
تتأثّر به، أو لم تتفاعل معها كتفاعلها مع ما تألفه.
فاللازم أن تُترك لكلّ فئة الحرية في أن تختار لنفسها الطريقة التي تناسبها في التعبير عن شعورها وعواطفها ما لم يتجاوز الحدّ المشروع.
إذ لو حرمت منه، وحملت على طريقة أُخرى لم تتجاوب معها، أو لم تتفاعل بها ذلك التفاعل، وخبت جذوة العاطفة فيها تدريجاً بمرور الزمن، وخسرنا طاقاتها في إبراز شعورها وعاطفتها نحو الحدث.
أهمية السواد الأعظم في حمل الدعوة والحفاظ عليها
كما إنّ الأحداث والتجارب من أعماق التاريخ حتى يومنا الحاضر قد أثبتت أنّ الذين يحملون لواء دعوة الحقّ وعناءه، ويستطيعون الاستمرار بها - عبر المعوّقات والمشاكل والمتاعب والمخاطر - هم جمهور المؤمنين وكثرتهم الكاثرة، وسوادهم الأعظم.
حيث إنّهم - بسبب كثرتهم - لا يسهل القضاء عليهم من قِبَل أعداء تلك الدعوة، ولا تجميد فعالياتهم وإيقاف مدّهم، ولا يتيسّر تبديل مفاهيمهم بالإغراء والتضليل.
ولاسيما أنّ مناسبات أهل البيت (صلوات الله عليهم) في أفراحهم وأحزانهم قد أخذت موقعها في نفوس عموم المؤمنين، وتجذّرت في أعماقهم؛ نتيجة انشدادهم لأهل البيت (عليهم السّلام) ولاءً وتقديساً كما ذكرناه سابقاً.
موقع الخاصة من الدعوة
أمّا الخاصة من المؤمنين - كرجال الدين والمثقّفين، وأهل المال، وذوي المقام الاجتماعي الرفيع - فهم وإن كان لهم موقعهم المهمّ في دعوة الحقّ، بل هم
أوسمة فخر تتزيّن به، وفيهم الهداة لأتباعها في مسيرتهم، والحصون الواقية للدعوة الشريفة نفسها من التحريف والتشويه، والقوى الداعمة لها مادياً ومعنوياً، إلّا إنّهم لا يستطيعون لوحدهم الوقوف أمام الهجمة المعادية؛ بسبب قلّتهم وتميّزهم.
بل يسهل على الأعداء الحدّ من فعالياتهم، والمنع من تأثيرهم؛ إمّا بتصفيتهم جسدياً، أو تطويقهم وتجميد فعالياتهم بالسجن أو التخويف أو نحوهم، أو صرفهم بالترغيب والترهيب عن خدمة دعوة الحقّ، بل قد يحاولون حملهم على الوقوف ضدّها.
ولا يحمي الدعوة الشريفة إلّا الجمهور والسواد الأعظم الذين يحملون لواءها؛ فهم الحصن الحصين لها، والدرع التي تقيها من كيد الأعداء كما سبق.
بل إنّهم - بسبب كثرتهم وإصرارهم - قد يحمون الخاصة من ذوي المقام المتميّز في الدعوة؛ لأنّ في التنكيل بهم جرحاً لشعور الجمهور، ومثاراً لسخطهم قد يحسب له الخصم حسابه، ويخشى عاقبته.
أهمية فعاليات الجمهور في إحياء المناسبات الدينية
ونتيجة لِما سبق يجب تمكين جمهور الناس والسواد الأعظم من الطريقة التي يختارونها في التعبير عن شعورهم في المناسبات الدينية المختلفة، بل تشجيعهم على ذلك بمختلف الوسائل؛ لتتجذر في أعماقهم، وتنتشر بينهم من أجل أن يؤدّوا دورهم الرسالي على أرض الواقع باستمرار وإصرار.
وليكونوا ذخراً في الأزمات، وأمام الضغوط التي تضطر الخاصة للوقوف مكتوفي الأيدي لا يستطيعون حتى الإشارة والتلميح بما يختلج في صدورهم، بل قد يضطرون أو يختار بعضهم - نتيجة المغريات - تثبيط العزائم
وإضعاف الهمم.
بينما نرى السواد الأعظم إذا اقتنعوا بإحياء المناسبات، وتجذّر ذلك في أعماقهم فهم أقدر على التمسّك بعاداتهم والاستمرار عليها؛ لأنّهم أبعد عن الضغوط، وأقدر على التخلّص منها أو الالتفاف عليها، ولنا في تجربة العراق القريبة أعظم العبر.
ويزيد في أهمية فعاليات الجمهور والسواد الأعظم أنّ كثرتهم، وسعة رقعة تواجدهم، واختيارهم في التعبير عن شعورهم الطريقة الأكثر إلفاتاً للحدث والأقوى وقعاً في التنبيه له، كلّ ذلك يجعل ممارساتهم سبباً في تبدّل جوّ المجتمع الذي يعيشون فيه، وتحويل صورته لصالح الحدث بنحو يدعو الجاهل، وينبّه الغافل، ويشدّ في اندفاع العامل، ويزيده ثباتاً وإصراراً وعزماً وتصميماً.
وبذلك تترك الممارسات المذكورة بصماتها في المجتمع وتجعله يعيش الحدث، ويتفاعل معه حتى يكون جزءاً من كيانه.
على الخاصة دعم الجمهور في إحياء المناسبات بطريقتهم
وإذا كانت الخاصة لا تستطيع المشاركة في هذه الممارسات عند الأزمات، بل قد لا تستطيع الإعلان عن شرعيتها فضلاً عن التشجيع عليها؛ للأسباب السابقة، فإنّها تستطيع ذلك كلّه عند انفراج الأزمة، وإطلاق الحريات.
فاللازم قيامها بذلك حينئذ من أجل رفع معنويات الجمهور، وإشعارهم بأهمّية موقعهم وموقفهم في إحياء المناسبات المذكورة، وتأكيد شرعية ذلك كلّه، وشكرهم عليه.
وبذلك تسدّ الطريق على مَنْ يحاول أن يفتّ في عضد الجمهور في ممارساتهم، ويحطّ من قدرهم، ويصمهم أو يشنّع عليهم بالجهل في قيامهم
بتلك الممارسات؛ من أجل تهوين أمرها، أو التنفير عنها، والحدّ من اتساعها وانتشارها.
ولاسيما أنّ هذه الممارسات لاتزال مدعومة بالمدّ الإلهي، والكرامات الباهرة، والمعاجز الخارقة التي يلمسها الناس بأيديهم ويعيشونها في واقعهم باستمرار؛ حيث يكشف ذلك عن حبّ الله (عزّ وجلّ) لها، وشكره للقائمين بها وتشجيعهم عليها.
بل لذلك أعظم الأثر في تمسّك الناس بها وإصرارهم عليها، واستمرارهم فيها رغم المعوّقات الكثيرة، والمقاومات العنيفة المادية والمعنوية على مدى الزمن.
أهمّية الممارسات الصارخة
الأمر الثاني: إنّ للممارسات الصارخة التي تلفت الأنظار، والتي يقوم بها كثير من جمهور الشيعة وعامتهم، ويتحمّلون عناءها وجهدها، أعظم الأثر في إحياء فاجعة الطفّ وانتشارها على الصعيد العام؛ لأنّها الأحرى بإظهار عواطف الجمهور نحو الفاجعة، وتفاعلهم بها، وتجذّرها في أعماقهم، واستنكارهم للظلم الذي تعرّض له الإمام الحسين وأهل البيت (صلوات الله عليهم) عموماً، كما تعرّض له شيعتهم تبعاً لهم على امتداد التاريخ.
كما إنّ هذه الممارسات هي الأحرى بإلفات نظر الآخرين وتنبيههم للحدث، وحملهم على السؤال والاستفسار عن حقيقته، والتعرّف على خصوصياته وتفاصيله، ثمّ التجاوب مع الشيعة واحترام شعورهم، والتفاعل معهم أو مشاركتهم في آخر الأمر، بل الدخول في حوزتهم والانتماء لخطّهم في ظلّ ولاية أهل البيت (صلوات الله عليهم).
وها نحن نرى هذه الأيام أثر هذه الممارسات في إلفات نظر العالم، وتوجيه وسائل الإعلام المختلفة نحو الفاجعة في مواسمها المشهودة.
وذلك يفسّر ما سبق في حديث معاوية بن وهب من دعاء الإمام الصادق (عليه السّلام) لزوّار الإمام الحسين (صلوات الله عليه)، وقوله: «اللّهمّ إنّ أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا، خلافاً منهم على مَنْ خالفنا؛ فارحم تلك الوجوه التي غيّرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تتقلّب على حضرة أبي عبد الله (عليه السّلام)، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا...»(١) .
نعم، لا بدّ أن ينضمّ إلى تلك الممارسات بعض الممارسات الهادئة، كقراءة المقتل الفجيع، ومجالس العزاء الشارحة لظروف الفاجعة وأهدافها، والكتب أو النشرات المتحدّثة عنها بإسهاب أو إيجاز، كلّ على اختلاف الظروف والمناسبات.
كلّ ذلك من أجل التثقيف العام، والتعريف بالحدث، والتذكير به، واستيعاب مفرداته ومقارناته التي تزيد في وقعه، والتفاعل به.
الكلام في تطوير طرق إحياء المناسبات
الأمر الثالث: قد يظنّ الظانّ أنّ تطوّر الأوضاع في العالم المعاصر يلزم بتطوير وسائل الدعوة للمبدأ وكيفية إحياء هذه المناسبات، وتبديلها بما يتلاءم مع واقع العصر وينسجم معها.
لكنّنا في الوقت الذي نحبّذ فيه إيجاد وسائل تناسب التطوّر المذكور، نرى أنّ ذلك يجب أن يكون مصاحباً لهذه الشعائر بواقعها المعهود المألوف لا بدلاً عنها.
فإنّ هذه الشعائر والممارسات حينما وجدت في غابر الزمان وجدت غريبة
____________________
١ - تقدّم في/٤٩٨ - ٤٩٩.
عن الواقع الذي قامت فيه حينئذٍ، وتعرّضت لأقسى أنواع المقاومة والتشنيع والتهريج كما يشير إليه ما سبق في دعاء الإمام الصادق (عليه السّلام) وغيره.
لكنّها ثبتت وفرضت نفسها متحدّية ذلك الواقع، وحقّقت أهدافها على أفضل وجوهها وأكملها، وكما لم تمنعها غرابتها من ذلك فيما مضى، فهي لا تمنعها منه في الوقت الحاضر بتسديد الله (عزّ وجلّ) ورعايته.
ولاسيما أنّ التطوير والتبديل المذكور كثيراً ما لا يتناسب مع واقع الجمهور ومداركه وأحاسيسه، فلا يتفاعل به، ولا يتجاوب معه، فلا يفي بالغرض كما سبق التعرّض له في الأمر الأوّل.
والعالم مليء بالممارسات والنشاطات التي تمتاز بها بعض الفئات والمجتمعات، وهي غريبة عن الآخرين من دون أن يمنعها ذلك من القيام بها والاستمرار عليها، كما لا تكون سبباً للتهريج والتشنيع على مَنْ يقوم بها. فلماذا التهريج والتشنيع هنا؟!
والظاهر أنّ من أهم أسباب التهريج على مَنْ يقوم بهذه الممارسات هو شعور أعداء التشيّع بالمكاسب العظيمة التي حصل عليها التشيّع بسببها على ما ذكرناه آنفاَ.
ومن هنا لا موجب للشعور بالضعف، ومحاولة التراجع لمجرّد كون الممارسات المذكورة غير مألوفة للآخرين، أو مورداً لاستغرابهم، أو استغلال الأعداء لذلك من أجل التهريج والتشنيع عليهم.
مضافاً إلى أمرين:
أوّلهما : إنّ تهيّب نقد الآخرين والاهتمام بإرضائهم تجعل الإنسان - من حيث يشعر أو لا يشعر - يضخّم التهريج والتشنيع، ويهولهما ويحيطهما بهالة من الأوهام والمبالغات، ويتخيّل كثيراً من ردود الفعل السيئة والسلبيات المترتبة
عليه من دون أن يكون لشيء من ذلك وجود على أرض الواقع، بل هي( كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ) (١) .
ولنا في التجربة الحاضرة أعظم شاهد على ذلك؛ فإنّ انفتاح العالم على التشيّع وعلى هذه الممارسات في بلادنا بدأ بعد الحرب العالمية الأولى حيث ارتفع حاجز التقيّة نسبياً، وبدأ العالم يتصل بعضه ببعض، وأخذت هذه الممارسات الصارخة تظهر للآخرين.
وقد بدأت سهام النقد والاستنكار لها في موجة (العلمانية الثقافية) التي حاولت اكتساح الدين عموماً، والاستهانة به وبممارساته كافة، وقد استشعر كثير ممّنْ ينتسب للدين بالضعف والوهن.
وحسب بعضهم أنّ هذه الممارسات هي سبب الحملة المذكورة، أو من أسبابه؛ فارتفعت أصواتهم باستنكارها باسم الإصلاح أملاً في رضى الآخرين؛ غفلة عن حقيقة الحال، لكنّه لم يفلح في منعها بسبب إصرار الجماهير غير المحدود عليها.
حتى إذا انحسرت تلك الموجة، واسترجع الدين موقعه في النفوس، وبدأ احترامه عالمياً لم نسمع صيحات الاستنكار لهذه الممارسات إلّا من قِبَل أعداء أهل البيت (صلوات الله عليهم)، ومن بعض مَنْ هو مغرم بالتجديد والتطوير حبّاً له، أو حذراً من نقد الآخرين.
ولذا لم توجب هذه الممارسات تأخّر التشيّع عالمياً في هذه المدّة الطويلة، بل هو في تقدّم مستمر رغم إغراق الجمهور الشيعي في الممارسات المذكورة وظهورها للعالم أجمع.
____________________
١ - سورة النور/٣٩.
وها نحن نرى أنّ اهتمام الإعلام العالمي هذه الأيام إنّما كان بتغطية ممارسات الشيعة في أنحاء المعمورة في إحياء ذكرى فاجعة الطفّ وعرضها، وبيان تعاطف الآخرين معها من دون أن يركّز على نقد هذه الممارسات والتشنيع عليها من قبل أعداء أهل البيت (عليهم السّلام)، وخصوم شيعتهم أو غيرهم بنحو يوحي بعزلة هؤلاء الناقدين والمهرّجين ويشعر بخيبتهم.
ثانيهما : إنّ التهريج والتشنيع حيث كان المقصود منه تراجع الشيعة عن هذه الممارسات، فإذا لم يجد أذناً صاغية خفّت تدريجاً؛ لشعور أصحابها بالخيبة والفشل، واضطروا للتعامل مع هذه الممارسات كما يتعاملون مع سائر الأمور المفروضة على أرض الواقع ممّا لا يعجبهم.
أمّا إذا وجد أذناً صاغية وبدأ الشيعة يتراجعون عن بعض هذه الممارسات من أجله، فإنّ القائمين بالتهريج والتشنيع يشعرون بنجاح مشروعهم؛ فيزيدون فيهما من أجل تراجع الشيعة عمّا تبقّى من هذه الممارسات حتى تُنسى هذه الفاجعة، ويخسر الشيعة أقوى دعامة لهم في نشر دعوتهم، وإسماع صوتهم وبيان ظلامتهم وامتداد وجودهم، وهو الذي يريده أعداؤهم على امتداد التاريخ.
الوظيفة عند اختلاف وجهات النظر
الأمر الرابع: إنّه قد تختلف وجهات النظر حول بعض الممارسات، إمّا للاختلاف في الحكم الشرعي اجتهاداً أو تقليداً، أو للاختلاف في حصول ما يؤكّد رجحانها ويقتضي التشبّث بها، أو يوجب مرجوحيتها ويقتضي الإعراض عنها من العناوين الثانوية.
واللازم حينئذ على كلّ طرف من أطراف الخلاف الاقتصار على بيان وجهة نظره، أو محاولة الإقناع به بالتي هي أحسن كما حثّ الشارع على ذلك
في سائر موارد الخلاف.
ولا ينبغي تجاوز ذلك إلى إرغام الغير على تقبّل وجهة نظره، أو الصراع الحاد والتشنجات، أو التهريج والتشنيع والتوهين... إلى غير ذلك ممّا يؤدّي إلى انشقاق الطائفة على نفسها، وتمزيق وحدتها، ووهنها أمام الآخرين، وشماتة الأعداء بها، بل قد يؤدّي إلى الإحراج في اتخاذ المواقف والتعامل مع الآخرين.
كما يؤدّي إلى هدر كثير من الطاقات المادية والمعنوية من أجل انتصار كلّ طرف لوجهة نظره، بدلاً من صرف تلك الطاقات لصالح هذه الطائفة المتعبة، وخدمة مشتركاتها، وتخفيف محنتها.
ومادامت الطائفة في وضعها الحالي تفقد الرعاية الظاهرة من الإمام المعصوم (صلوات الله عليه وعجّل فرجه)، ولا يتيسّر لها تحكيمه في خلافاتها، فلا يحقّ لأيّ شخص فرض وجهة نظره على غيره، أو التعدّي عليه مادياً أو معنوياً؛ لعدم قناعته برأيه وانصياعه له.
دعوى اختصاص أهمّية الإحياء بما إذا كان مقارعة للظلم
الأمر الخامس: إنّه قد يدّعي المدّعي أنّ أهمّية هذه الأمور تختصّ بالظروف الحرجة حيث يكون القيام بها صراعاً مع الظلم والطغيان، وجهاداً مريراً في سبيل الدعوة إلى الله، ولا حاجة للتأكيد عليها مع الانفتاح والحرية، بل تبقى عادات صرفة، وتقاليد مجرّدة، لا أهمية لها، ولا جهد ولا جهاد في البقاء عليها، ولا تكون مورداً للحثّ الشرعي، ولا للأجر الموعود به عليها.
دفع الدعوى المذكورة
لكن لا مجال للبناء على ذلك:
أوّلاً : لأنّ فوائد هذه الأمور لا تختصّ بالصراع مع الظالمين والجهاد في وجه الطغيان، بل لها فوائد أُخرى مهمّة جدّاً سبق التعرّض لها في المطلب الثاني عند التعرّض لما كسبه التشيّع من فاجعة الطفّ.
والأهم من الكلّ حثّ الشارع الأقدس عليها بوجه مؤكّد، وما أعدّه من الأجر العظيم والثواب الجزيل لمَنْ يقوم به من دون أن يتضمّن التقييد بزمان خاص أو حال خاص، كما هو الحال في الحجّ والعمرة وغيرهما من الواجبات والمستحبات الشرعية. فالتقييد المذكور تخرّص في تحريف الحكم الشرعي.
وثانياً : لأنّ الشيعة حينما بدأوا بهذه الممارسات - بدفع من الأئمّة (صلوات الله عليهم) - لم يكونوا في مقام مواجهة الطغاة ومقارعتهم بها، بل قاموا بها بصورة فردية سرّية خوفاً من الظالمين، ولم يكن الدافع لهم إلّا الأخذ بتوجيهات أهل البيت (صلوات الله عليهم)، والسير على تعاليمهم، وتأكيد الولاء لهم، وأداء حقّهم.
وخاصةً الإمام الحسين (عليه السّلام) الذي يتميّز بموقع عاطفي عميق في نفوس الشيعة؛ نتيجة فاجعة الطفّ وأبعادها المأساوية المثيرة.
غاية الأمر أنّ ظهور قيام الشيعة بهذه الممارسات، وإصرارهم عليها تدريجاً، أثار حفيظة الظالمين؛ فجدّوا في منعها والتنكيل بالقائمين بها، وبدأ الصراع بين الطرفين نتيجة ذلك.
فالصراع مع الطغاة ومقارعتهم أمر طارئ على هذه الممارسات من دون أن يكون مأخوذاً في صميمها، ولا سبباً للحثّ عليه، أو شرطاً فيها.
وثالثاً : لأنّ كثيراً من هذه الممارسات التي ورد الحثّ عليها، والوعد بالأجر والثواب عليها تبتني على التخفّي والتستّر من دون أن يكون لها مظهر يثير الطغاة ويزعجهم، مثل ما تضمّنته رواية مسمع كردين الآتية في
الأمر الثامن، ونحوها غيره، وما ورد مستفيضاً في زيارة مَنْ بعدت شقته.
ففي حديث طويل لسدير، قال أبو عبد الله (عليه السّلام): «يا سدير، وما عليك أن تزور قبر الحسين (عليه السّلام) في كلّ جمعة خمس مرّات، وفي كلّ يوم مرّة».
قلت: جعلت فداك، إنّ بيننا وبينه فراسخ كثيرة.
فقال: «تصعد فوق سطحك، ثمّ تلتفت يمنة ويسرة، ثمّ ترفع رأسك إلى السماء، ثمّ تتحرّى نحو قبر الحسين (عليه السّلام)، ثمّ تقول: السّلام عليك يا أبا عبد الله، السّلام عليك ورحمة الله وبركاته. يكتب لك زورة. والزورة حجّة وعمرة».
قال سدير: فربما فعلته في النهار [الشهر] أكثر من عشرين مرّة(١) . وورد نحو ذلك في زيارة بقيّة المعصومين (صلوات الله عليهم).
ومن الظاهر أنّ مثل هذه الزيارة لا ظهور لها، ولا مظهر فيها لمقارعة الطغاة والصراع مع الظالمين، والجهاد في سبيل الله تعالى، بل تتمحّض في كونها مظهراً للولاء، وسبباً لتأكيد الانشداد لأهل البيت (عليهم السّلام).
وإذا كانت مثل هذه الزيارة الخفيفة المؤونة تعدل حجّة وعمرة فكيف يكون حال زيارة القاصد من مسافة بعيدة، والذي يبذل جهداً بدنياً أو مالياً مكثفاً في سبيل الوصول للقبر الشريف وأداء حقّ المزور (عليه السّلام)؟
وذلك كلّه وغيره يشهد بأنّ تشريع هذه الممارسات وترتّب الثواب العظيم عليها ليس من أجل الجهاد ومقارعة الظلم والطغيان، بل لكونها مظهراً للولاء لأهل البيت (صلوات الله عليهم)، وسبباً للانشداد لهم، وأداءً لعظيم حقّهم وغير ذلك من الفوائد المتقدّمة.
غاية الأمر أنّ ذلك قد يثير الطغاة والظالمين؛ إمّا لعدائهم لأهل البيت (صلوات الله عليهم)، أو لعدائهم للتشيّع كعقيدة دينية،
____________________
١ - كامل الزيارات/٤٨٠ - ٤٨١، واللفظ له، الكافي ٤/٥٨٩.
وشعورهم بأنّ هذه الممارسات سبب لتركيزها، وتقوية كيان الشيعة، وبعث الحيوية فيهم.
ورابعاً : لأنّ الصراع بها مع الظالمين، والجهاد والثبات عليها في وجه الطغاة عند منعهم يتوقّف على الثبات عليها في حال الرخاء، والتمسّك بها في حال الدعة؛ لأنّها بذلك تصبح جزءاً من كيان الأُمّة، ومن موروثاتها العريقة المقدّسة التي يصعب عليها تركها والتجرّد منها.
ويكون منع الطغاة لها جرحاً لشعور الأُمّة وتعدّياً عليها بنظر كلّ منصف، فيكون من حقّها الطبيعي أن تثأر لكرامتها، وتبدأ ردود الفعل والصراع المرير بينها وبين الطغاة؛ لتثبيت شخصيتها، والثبات على عاداتها وموروثاتها، والحفاظ على مقدّساتها.
أمّا إذا تهاونت بها في حالة الرخاء والدعة، ولم تؤكّد عليها ولا تمسّكت بها فهي لا تستطيع القيام بها في حالة الشدّة ومنع الطغاة لها:
أوّلاً : لعدم تفاعلها معها وعدم اعتزازها بها؛ بسبب ألفتها لتركها حيث لا يكون لها من القوّة والتركز في نفوسها ما يدفعها للقيام بها، والصراع والتضحية في سبيلها.
وثانياً : لأنّ الحاكم لا يكون معتدياً في منعه لها؛ ليكون للأُمّة المبرّر في مقاومته والصراع معه، بل تكون الأُمّة هي المتعدّية والملومة في إقامتها والاهتمام بها بعد أن لم تكن متمسّكة بها من قبل.
حيث تتمحّض النشاطات المذكورة في تحدّي الحاكم، والشغب ضدّه، وسبباً طبيعياً لإثارته، ومبرّراً له في منعها، والتنكيل بمَنْ يقوم بها، وقمعه وإنزال عقابه به، وقسوته معه، وتخسر الأُمّة أخيراً الصفقة في
الصراع، وهذا أمر حقيق بالتأمّل والتدبّر، والله سبحانه من وراء القصد، وهو المسدّد.
تأكيد رجحان إحياء المناسبات المذكورة في بعض الحالات
نعم، إحياء هذه المناسبات - كغيره من جهات الخير - يتأكّد رجحانه، ويزيد ثوابه إذا ترتّب عليه أمر آخر راجح في نفسه، كتشجيع الآخرين على الخير، وإغاظة الظالمين، وكمقارعة الظلم والطغيان، والجهاد في سبيل إعلان دعوة الحقّ وإعلاء كلمة الله (عزّ وجلّ) وغير ذلك؛ لتعدّد سبب الثواب فيه حينئذٍ.
ويناسب ذلك ما تضمّنته النصوص الكثيرة من الحثّ على زيارة الإمام الحسين (صلوات الله عليه) على خوف ووجل(١) ، وإن كان تحديد ذلك فقهياً موكولاً إلى محلّه.
لكنّ ذلك أمر آخر غير ما سبق من دعوى اختصاص أهمّية إحياء المناسبات الشرعية بما إذا كان في إحيائها مقارعة للظلم إلى آخر ما سبق.
في آداب إحياء المناسبات المذكورة
الأمر السادس : إنّه لا بدّ أوّلاً: من الحفاظ على قدسية هذه الممارسات ونزاهتها، وعدم الخروج بها عن الضوابط الشرعية، وحسن سلوك القائمين بها، والتزامهم الديني والخلقي. وقد أكّد أئمّتنا (صلوات الله عليهم) على ذلك عموم، ومن الطبيعي أن يكون رجحان ذلك هنا آكد، بل قد ورد عنهم (عليهم السّلام) في بيان آداب الزيارة الشيء الكثير.
____________________
١ - كامل الزيارات/٢٤٢ - ٢٤٥.
وثانياً : من التأكيد على جانب الشجا والحزن، وما هو الأحرى باستثارة العاطفة والحسرة، واستدرار الدمعة في مناسبات الأحزان ومجالس العزاء. وليكن الإبداع واستعمال الطاقات منصبّاً إلى هذا الجانب ومعنيّاً به.
ولا يكون الغرض متمحّضاً في الإبداع والتفنن والتجديد من دون مراعاة لهذه الجهة؛ فإنّ في ذلك خروجاً بهذه الممارسات عن أهدافها السامية التي أكّد عليها أئمّتنا (صلوات الله عليهم)، وتحجيماً لدورها في خدمة المذهب الحقّ، وتنقلب إلى مباريات فنّية عقيمة.
وثالثاً : من إبعادها عن أن تكون مسرحاً لإبراز العضلات والتسابق والتشاح من أجل إظهار المميّزات والقدرات الشخصية أو نحوها؛ لإلفات الأنظار، وحبّاً في السمعة والجاه، ونحو ذلك ممّا لا يناسب قدسية هذه الممارسات وسمو أهدافها، وشرف انتسابها لأهل البيت (صلوات الله عليهم).
وأولى بذلك إبعادها عن المحرّمات، كالموسيقى والتبرّج؛ فإنّها مناسبات دينية روحانية مقدّسة يفترض فيها أن تذكّر بالله (عزّ وجلّ)، وبقدسية أوليائه وأصفيائه، وتكون رادعة عن كلّ ما لا يناسب ذلك.
وهذا يجري حتى في مناسبات الأفراح، كالمواليد الشريفة ونحوها؛ لأنّها تتعلّق بزمرة القديسين الذين هم سفراء الله (عزّ وجلّ) الناطقون عنه والمذكرون به، والذين هم مثال الالتزام الديني والأخلاقي.
فنحن في الوقت الذي نفرح فيه لإنعام الله تعالى على البشرية بهم، ونشكر الله تعالى على توفيقنا لموالاتهم والانتساب لهم، وإحياء أمرهم، والفرح لفرحهم، والحزن لحزنهم، علينا أن نؤدّي فروض شكر ذلك بطاعة الله تعالى وتجنّب معصيته، والحفاظ على هيبة تلك الشعائر وقدسيتها.
وليكن في مرتكز القائمين بها وقرارة نفوسهم أنّ المعصومين (صلوات الله عليهم) - خصوصاً إمام العصر (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) - يشرفون على هذه النشاطات والممارسات أو يشاركونهم فيها؛ ليكون سلوكهم وأداؤهم مناسباً لذلك، ومنسجماً معه.
بل الله (عزّ وجلّ) لا تخفى عليه خافية، وهو من ورائهم محيط، وبيده أسباب التوفيق والخذلان، والثواب والعقاب؛ فاللازم مراقبته في كلّ صغيرة وكبيرة تتعلّق بهذه الأمور، وعدم الخروج بها عمّا يريده (جلّ شأنه) منها.
ولاسيما أنّ الأعداء والمنحرفين يضيقون ذرعاً به، ويحاولون تهوين أمره، بل تنشيعه، ويستغلّون الثغرات والسلبيات؛ فيغرقون في تضخيمها والتشنيع بها أملاً في صرف الناس عن هذه النشاطات، وتنفيرهم منها، وحملهم على الاستهانة بها أو تركها؛ فلا يحسن بنا أن نعينهم على أنفسنا، ونحقّق لهم ما يريدون.
لا تكن هذه المناسبات مسرحاً للصراعات
الأمر السابع: اللازم عدم الخروج بهذه الممارسات عمّا شُرّعت له من إحياء أمر أهل البيت (عليهم السّلام) - في التذكير بمظلوميتهم، ورفيع مقامهم، ونشر تعاليمهم، وما جرى هذا المجرى - إلى أمور خارجة عن ذلك؛ لتكون معرضاً للشعارات المختلفة، ومسرحاً للصراعات الحادّة، والاتجاهات المتباينة التي لا يخلو منها زمان ولا مكان؛ فإنّ ذلك يشوّه صورتها ويوجب الزهد فيها، بل قد يتخذ ذريعة لمنعها، ومبرّراً للقضاء عليها كما مرّت لنا في ذلك تجارب سابقة.
وبذلك - لا سمح الله - نكون قد خسرنا أضخم دعامة لمذهب أهل البيت (صلوات الله عليهم) حملت لواءه على مرّ العصور وتعاقب الدهور، وشدّة المحن
وظلمات الفتن، ونتحمّل مسؤولية ذلك أمام الله تعالى، وأمام أهل البيت (عليهم السّلام) ومبادئهم السامية.
بل ينبغي أن تنسى أو تتناسى الخلافات في سبيل وحدة الهدف من هذه الممارسات وشرفها، وتكون المناسبات المذكورة محفّزة على التقارب والتركيز على الثوابت والمشتركات.
أهمّية الجهد الفردي مهما تيسّر
الأمر الثامن: من الظاهر أنّ الداعي لإحياء هذه المناسبات الشريفة هو الحبّ والولاء لأهل البيت (صلوات الله عليهم) الذي ينبض به قلب المؤمن، ويصرخ في أعماق نفسه.
وفي حديث الأربعمئة المعتبر عن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) أنّه قال: «إنّ الله تبارك وتعالى اطّلع إلى الأرض فاختارنا، واختار لنا شيعة ينصروننا، ويفرحون لفرحنا، ويحزنون لحزننا، ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا، أولئك منّا وإلينا»(١) . وقد أكّد ذلك الحثّ الشرعي المكثّف، كما أشرنا إليه آنفاً.
ونتيجة لذلك كلّه يندفع المؤمن لإبراز شعوره على أرض الواقع بدافعه الشخصي النابع من قلبه، بما يتيسّر له من وسائل التعبير عن هذا الشعور من دون أن يتوقّف على أمر آخر؛ من تجمّع، أو تنظيم، أو قدرات خاصة... إلى غير ذلك ممّا قد لا يتيسّر لبعض الناس، أو في بعض الأوقات أو الأحوال.
وكلّ جهد في ذلك - مهما قلّ - مقبول إن شاء الله تعالى بعد شرف الغاية وسمّوها، وعظيم الثمرة وبركتها.
____________________
١ - الخصال/٦٣٥، واللفظ له، بحار الأنوار ١٠/١١٤.
حديث مسمع كردين
وفي حديث مسمع كردين عن الإمام الصادق (عليه السّلام) قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السّلام): «يا مسمع، أنت من أهل العراق، أما تأتي قبر الحسين (عليه السّلام)؟».
قلت: لا، أنا رجل مشهور عند أهل البصرة. وعندنا مَنْ يتبع هوى هذا الخليفة. وعدوّنا كثير [وأعداؤنا كثيرة] من أهل القبائل من النصّاب وغيرهم؛ ولست آمنهم أن يرفعوا حالي عند ولد سليمان فيمثّلون بي [فيميلون عليّ].
قال لي: «أفما تذكر ما صُنع به؟». قلت: نعم. قال: «فتجزع؟». قلت: إي والله، وأستعبر لذلك حتى يرى أهلي أثر ذلك عليّ، فأمتنع من الطعام حتى يستبين ذلك في وجهي. قال: «رحم الله دمعتك. أما إنّك من الذين يُعدّون من أهل الجزع لنا، والذين يفرحون لفرحنا، ويحزنون لحزننا، ويخافون لخوفنا، ويأمنون إذا أمنا.
أما إنّك سترى عند موتك حضور آبائي لك، ووصيتهم ملك الموت بك، وما يلقونك به من البشارة أفضل، وملك الموت أرقّ عليك وأشدّ رحمة لك من الأم الشفيقة على ولدها...»(١) .
وهذا من أهم أسباب استمرار شيعة أهل البيت (رفع الله تعالى شأنهم) في إحياء مناسباتهم الشريفة، وعدم انقطاعهم عنها رغم المعوّقات الكثيرة والصراع المرير؛ لأنّ التجمّع والقيود والرتابة وغيرها كثيراً ما لا تتيسّر للفرد وللمجتمع، فلو كان ذلك عائقاً عن إحيائها لتركوه في فترة تعذّر هذه الأمور.
وبتركهم له تخبو جذوة العاطفة نحو الحدث، ويُنسى تدريجاً، ويحتاج تذكيرهم به وإرجاعهم إلى ما كانوا عليه إلى جهود مكثفة قد لا تتيسّر، بل قد لا تثمر.
____________________
١ - كامل الزيارات/٢٠٣ - ٢٠٤، واللفظ له، بحار الأنوار ٤٤/٢٨٩ - ٢٩٠.
بخلاف ما إذا شعر كلّ فرد منهم بأنّه يستطيع الاستمرار في إحياء المناسبات المذكورة ولو لوحده، وبما يتيسّر له وإن قلّ، فإنّ ذلك موجب لاستمراره في التفاعل بالمناسبة وفي إحيائها، وفي نقمته وتنمّره من الضغوط الخانقة والعوائق المانعة من تكثف الإحياء وتوسّعه.
حتى إذا ارتفعت العوائق، وانكسر الطوق الخانق انفجر المخزون العاطفي للأفراد؛ ليشكّل مظهراً جماهيرياً في إحياء المناسبات يهزّ المجتمع ويدفعه بالاتجاه المذكور؛ ليحقّق أفضل النتائج كما حصل عياناً في مناسبات كثيرة، ومنها تجربة العراق الأخيرة.
فاللازم بالدرجة الأولى الاهتمام بالجهد الفردي مهما تيسّر، والحفاظ عليه والتشبّث به وعدم الاستهانة به مهما قلّ، ثمّ الاهتمام بتكثيفه وتوسّعه كمّاً وكيفاً مهما أمكن، تبعاً لاختلاف الظروف والأحوال، والله (عزّ وجلّ) وراء ذلك، وهو المسبب للأسباب والميسّر لها، وإليه يرجع الأمر كلّه.
ثبوت الأجر العظيم على إحياء أمرهم (عليهم السّلام)
الأمر التاسع: استفاضت النصوص، بل تواترت إجمالاً بعظيم أجر إحياء أمر أهل البيت (صلوات الله عليهم)، وخصوصاً ما يتعلّق بالإمام الحسين (عليه السّلام) في زيارته والبكاء عليه، وقول الشعر فيه وغير ذلك على اختلاف أنحاء الأجر من غفران الذنوب، وإثبات الحسنات، ورفع الدرجات، وضمان الجنّة، والوعد بالشفاعة وغير ذلك كلّ بوجه مكثّف، وبنحو مذهل كما يظهر بأدنى ملاحظة لتراث أهل البيت (صلوات الله عليهم).
وذلك إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على أهمية إحياء أمرهم (صلوات الله عليهم) دينياً بنحو يناسب الثمرات المهمّة له في صالح الدين على النحو الذي تقدّم شرحه في محاولتنا هذه.
شبهة أنّ ذلك يشجع على المعصية
نعم، ربما حامت الشبه أو الوساوس حول ذلك في محاولة استبعاده - رغم استفاضة النصوص به، كما تقدّم - لدعوى أنّ في ذلك فسح الطريق للقائمين بممارسات الإحياء لأن يقارفوا المعاصي، ويأمنوا عقابها ومغبّتها نتيجة ممارساتهم المذكورة.
بل قد يبلغ حدّ التشجيع عليه بلحاظ ما هو المعلوم من كون كثير من المعاصي مرغوباً نفسيّاً رغبة ملحّة؛ نتيجة الشهوة العارمة، والغرائز المتوثّبة، فالتنبيه على غفرانها بهذه الممارسات يؤول إلى التشجيع عليها.
دفع الشبهة المذكورة
لكن من الظاهر أنّ ذلك لا يختصّ بإحياء مناسبات أهل البيت (صلوات الله عليهم) وجميع ما يتعلّق بهم، بل ورد في غيرها أيضاً.
قال الله (عزّ وجلّ):( وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِّنَ الليْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ) (١) .
وفي صحيح الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السّلام) الوارد في شامة ظهرت في آدم لما هبط إلى الأرض اسودّ منها جسمه، وأنّ جبرئيل (عليه السّلام) هبط عليه وأمره بالصلوات الخمس، فكلّما صلّى واحدة انحطّت الشامة بسوادها للأسفل حتى إذا صلّى الخامسة خرج من الشامة، وابيضّ جسمه. فقال له جبرئيل (عليه السّلام): «يا آدم، مثل ولدك في هذه الصلاة كمثلك في هذه الشامة. مَنْ صلّى من ولدك في كلّ يوم وليلة خمس صلوات
____________________
١ - سورة هود/١١٤.
٢ - وسائل الشيعة ٣/٩ - ١٠ باب ٢ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ٩.
خرج من ذنوبه كما خرجت من هذه الشامة»(١) .
وممّا ورد عن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) قوله: «تعاهدوا أمر الصلاة، وحافظوا عليها، واستكثروا منها، وتقرّبوا بها؛ فإنّها كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً...، وإنّها لتحُتّ الذنوب حتّ الورق، وتطلقها إطلاق الرَبَق(٢) ، وشبهها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحِمّة(٣) تكون على باب الرجل فهو يغتسل منها في اليوم والليلة خمس مرّات، فما عسى أن يبقى عليه من الدَرَن(٤) ...»(٥) .
وفي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحجّ والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد»(٦) .
وفي موثق السكوني عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال: «إنّ الله (عزّ وجلّ) ليغفر للحاج ولأهل بيت الحاج ولعشيرة الحاج ولمَنْ يستغفر له الحاج بقيّة ذي الحجّة، والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأوّل وعشر من شهر ربيع الآخر»(٧) ... إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة جدّاً الواردة في الصلاة والحجّ وغيرهم.
ومجرّد الوعد أو القطع بغفران الذنوب لا يقتضي التأمين منها المستلزم للتشجيع عليها، بل هو - نظير الحثّ على التوبة والوعد بغفران الذنوب معها - من أسباب صلاح الإنسان؛ لأنّ شعوره بالتخلّص من تبعة الذنوب والتخفّف
____________________
١ - وسائل الشيعة ٣/٩ - ١٠ باب ٢ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ٩.
٢ - الرَبَق: جمع ربقة، وهي عروة الحبل. وقد شبه (عليه السّلام) الذنوب بعرى الحبل التي يربق بها الأسرى، والصلاة تطلق المذنب منه.
٣ - الحِمة: العين الحارة الماء، يستشفي بها الأعلاء والمرضى.
٤ - الدرن: الوسخ.
٥ - نهج البلاغة ٢/١٧٨ - ١٧٩.
٦ - وسائل الشيعة ٨/٧٤ باب ٣٨ من أبواب وجوب الحجّ والعمرة وشرائطه ح ٤٣.
٧ - وسائل الشيعة ٨/٧١ باب ٣٨ من أبواب وجوب الحجّ والعمرة وشرائطه ح ٣١.
منه، وبشرف علاقته بالله (عزّ وجلّ)، وقبوله تعالى له، ودخوله في حظيرة طاعته سبحانه، وكونه مورداً لفيضه وثوابه، واستشعاره لذّة ذلك، وانشراح صدره به، كلّ ذلك يكون محفّزاً له على المزيد حتى قد ينتهي بصلاحه وتهذيب نفسه وبعده عن التمرّد والعصيان.
وكلّما كان الحثّ من الشارع الأقدس على العمل القربي أشدّ، والثواب عليه أكثر كشف عن أهمّيته وشدّة قرب القائم به والمؤدّي له عند الله تعالى، وكان أحرى بإصلاح الإنسان، وحمله على طاعة الله (عزّ وجلّ)، وإبعاده عن معصيته.
ولاسيما إذا كان العمل بنفسه مدرسة تربوية تهذّب الإنسان وتذكّره بالله تعالى، كالصلاة بأفعالها وأذكارها، والحجّ بمناسكه ومشاعره، وإحياء أمر أهل البيت (صلوات الله عليهم) وما يتعلّق بهم ممّا يوجب الانشداد لهم وتأكّد حبّهم والتعلّق بهم، والتعرّف على تعاليمهم وسلوكهم حيث يوجب القبول منهم والتفاعل بسيرتهم وتعاليمهم.
ولذا لم نعهد مؤمناً ملتزماً في نفسه قد تحلّل وقارف المعاصي نتيجة توفيقه لمثل الصلاة والحجّ، وإحياء مناسبات أهل البيت (عليهم السّلام) اتكالاً على عظيم الثواب عليها وتكفيرها للذنوب.
بينما نعهد الكثير من غير الملتزمين قد صار توفيقهم لشيء من هذه الأمور محفّزاً لهم على الالتزام الديني تدريجاً، وسبباً لصلاحهم وتهذيبهم.
لا محذور في التركيز على نصوص الأجر والثواب
وممّا ذكرنا يظهر أنّه لا مجال لدعوى أنّ النصوص الشريفة وإن تضمّنت الثواب العظيم على إحياء أمر أهل البيت (صلوات الله عليهم)، وخصوصاً ما
يتعلّق بالإمام الحسين (عليه السّلام) لمصالح هم (عليهم السّلام) أعلم به، إلّا إنّه لا يحسن الإعلان بذلك والتأكيد عليه أمام الجمهور؛ حذراً من اغترارهم بذلك وتسامحهم دينياً اتكالاً عليه.
حيث اتضح ممّا سبق أنّه لا منشأ للحذر المذكور على أنّ النصوص إنّما وردت لإعلام المؤمنين بمضامينها، وحثّهم على هذه الممارسات من طريق ذلك. فلا وجه لكتمان ذلك، والامتناع من إعلامهم بها.
رجحان الوعظ والتذكير باهتمام أهل البيت (عليهم السّلام) بالالتزام الديني
نعم، من الراجح جدّاً وعظ القائمين بهذه الممارسات وحملهم على الالتزام الديني، وتنبيههم إلى حثّ أهل البيت (صلوات الله عليهم) لشيعتهم أن يعينوهم بالتقوى والورع، ويتنافسوا في الدرجات وأن يكونوا زيناً لهم، ولا يكونوا شيناً عليهم، وإلى أنّ أعمالهم تُعرض على النبي والأئمّة من آله (صلوات الله عليهم أجميعن) فما كان فيها من حسن سرّهم، وما كان فيها من سيء أساءهم(١) .
بل الله (عزّ وجلّ) محيط من ورائهم بكلّ شيء، فقد يكون تورّط العبد بالموبقات سبباً لمقته له مقتاً يستتبع خذلانه تعالى إيّاه، وسلب نعمة الولاية لأهل البيت (عليهم السّلام) منه... إلى غير ذلك من وجوه الترغيب والترهيب. وقد سبق أنّ مناسبات إحياء أمرهم (عليهم السّلام) مواسم للتثقيف، خصوصاً الديني منه.
وذلك أولى من التشكيك فيما استفاض من نصوص أجر الأعمال الصالحة ونصوص الشفاعة ونحوها، أو إغفالها وحرمان جمهور المؤمنين من الاطلاع عليها؛ حذراً من اتكالهم عليها؛ لأنّ ما ذكرنا هو الأنسب بغرض أهل البيت (صلوات الله عليهم) من بيان تعاليمهم الشريفة وثقافتهم الرفيعة.
____________________
١ - راجع وسائل الشيعة ١١ باب ١٠١ من أبواب جهاد النفس.
حديث يزيد بن خليفة
وبالمناسبة قد يحسن ذكر معتبر يزيد بن خليفة، وهو رجل من بني الحارث بن كعب قال: أتيت المدينة وزياد بن عبيد الله الحارثي عليه، فاستأذنت على أبي عبد الله (عليه السّلام)، فدخلت عليه وسلّمت عليه وتمكّنت من مجلسي.
قال: فقلت لأبي عبد الله (عليه السّلام): إنّي رجل من بني الحارث بن كعب، وقد هداني الله (عزّ وجلّ) إلى محبّتكم ومودّتكم أهل البيت. قال: فقال لي أبو عبد الله (عليه السّلام): «وكيف اهتديت إلى مودّتنا أهل البيت؟ فوالله إنّ محبّتنا في بني الحارث بن كعب لقليل».
قال: فقلت له: جعلت فداك، إنّ لي غلاماً خراساني، وهو يعمل القصارة، وله همشهريجون(١) [همشهرجين] أربعة، وهم يتداعون كلّ جمعة، فيقع الدعوة على رجل منهم، فيصيب غلامي كلّ خمس جمع جمعة، فيجعل لهم النبيذ واللحم. قال: ثمّ إذا فرغوا من الطعام واللحم جاء بإجانة فملأها نبيذاً، ثمّ جاء بمطهّرة، فإذا ناول إنساناً منهم قال له: لا تشرب حتى تصلّي على محمد وآل محمد، فاهتديت إلى مودّتكم بهذا الغلام.
قال: فقال لي: «استوص به خيراً، واقرأه منّي السّلام، وقل له: يقول لك جعفر بن محمد: انظر شرابك هذا الذي تشربه فإنّ كان يسكر كثيره فلا تقربنّ قليله؛ فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كلّ مسكر حرام. وقال: ما أسكر كثيره فقليله حرام».
قال: فجئت إلى الكوفة، وأقرأت الغلام السّلام من جعفر بن محمد (عليهم السّلام). قال: فبكى. ثمّ قال لي: اهتمّ بي جعفر بن محمد (عليهم السّلام) حتى يقرئني السّلام؟! قال: قلت: نعم. وقد قال لي: قل له: «انظر شرابك هذا الذي تشربه، فإنّ كان يسكر
____________________
١ - يعني: جماعة من أهل بلده. والكلمة فارسية الأصل.
كثيره فلا تقربنّ قليله؛ فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كلّ مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام». وقد أوصاني بك. فاذهب فأنت حرّ لوجه الله تعالى. قال: فقال الغلام: والله، إنّه لشراب ما يدخل جوفي ما بقيت في الدنيا(١) .
هذا ما تيسّر لنا من الحديث عن إحياء فاجعة الطفّ وجميع مناسبات أهل البيت (صلوات الله عليهم) وما يتعلّق بذلك.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدّ القائمين بإحياء هذه المناسبات بالتسديد والتأييد، ويشدّ من أزرهم، ويوفّقهم لاختيار الطريق الأمثل في خدمة قضيتهم ومبدئهم، ويتقبّلها منهم، ويشكر سعيهم، ويُعظِم أجرهم، ويدفع عنهم، ويعزّ نصرهم، ويزيدهم إيماناً وتسليماً، وتوفّيقاً لطاعته ومجانبة معصيته.
كما نسأله عز وجل أن يشركنا في ثوابهم، وفي صالح أدعيتهم، ويوفقنا لنكون منهم، ونحسب عليهم إنّه أرحم الراحمين، وولي المؤمنين.
وبهذا ينتهي الكلام في المقام. وكان ذلك يوم الجمعة السادس من شهر محرّم الحرام. سنة ألف وأربعمئة وثمان وعشرين للهجرة النبوية (على صاحبها وآله أفضل الصلاة والتحية). في النجف الأشرف، بيمن الحرم المشرّف (على مشرّفه الصلاة والسّلام). بقلم العبد الفقير (محمد سعيد) (عُفي عنه)، نجل سماحة آية الله (السيد محمد علي) الطباطبائي الحكيم (دامت بركاته). حامداً مصلّياً مسلّماً، وحسبنا الله ونِعْمَ الوكيل.
كما انتهى إعادة النظر فيه وإضافة الشيء الكثير له ليلة الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك سنة ألف وأربعمئة وتسعة وعشرين للهجرة بيمنى مؤلّفه (عُفي عنه) حامداً مصلّياً مسلّماً.
____________________
١ - الكافي ٦/٤١١.
ملحق رقم (١)
خطبة الزهراء (عليه السّلام) الكبرى
قال الطبرسي(١) : روى عبد الله بن الحسن بإسناده عن آبائه (عليهم السّلام): أنّه لما أجمع أبو بكر وعمر على منع فاطمة (عليها السّلام) فدكاً وبلغها ذلك لاثت خمارها على رأسها، واشتملت بجلبابها، وأقبلت في لمّة من حفدتها ونساء قومها تطأ ذيولها(٢) ، ما تخرم مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى دخلت على أبي بكر، وهو في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم. فنيطت دونها ملاءة، فجلست ثمّ أنّت أنّة أجهش القوم لها بالبكاء؛ فارتّج المجلس، ثمّ أمهلت هنيئة حتى إذا سكن نشيج القوم وهدأت فورتهم، افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله، فعاد القوم في بكائهم.
فلمّا أمسكوا عادت في كلامها، فقالت (عليه السّلام): «الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدّم؛ من عموم نِعَمٍ ابتدأها، وسبوغ آلاء أسداها، وتمام منن أولاها، جمّ عن الإحصاء عددها، ونأى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بإجزالها، وثنى بالندب إلى أمثالها.
وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له. كلمة جعل الإخلاص تأويلها، وضمّن القلوب موصولها، وأنار في التفكّر معقولها. الممتنع من الأبصار رؤيته،
____________________
١ - الاحتجاج ١/١٣١ - ١٤١.
٢ - يعني: ذيول ثيابه. وهو ما يجرّ منها على الأرض لطوله.
ومن الألسن صفته، ومن الأوهام كيفيته.
ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها، وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها. كوّنها بقدرته، وذرأها بمشيته، من غير حاجة منه إلى تكوينها، ولا فائدة له في تصويرها إلّا تثبيتاً لحكمته، وتنبيهاً على طاعته، وإظهاراً لقدرته، تعبّداً لبريته، وإعزازاً لدعوته، ثمّ جعل الثواب على طاعته، ووضع العقاب على معصيته، ذيادة(١) لعباده من نقمته، وحياشة(٢) لهم إلى جنّته.
وأشهد أنّ أبي محمداً عبده ورسوله. اختاره قبل أن أرسله، وسمّاه قبل أن اجتباه، واصطفاه قبل أن ابتعثه؛ إذ الخلائق بالغيب مكنونة، وبستر الأهاويل مصونة، وبنهاية العدم مقرونة. علماً من الله تعالى بمآيل الأمور(٣) ، وإحاطة بحوادث الدهور، ومعرفة بموقع المقدور. ابتعثه الله إتماماً لأمره، وعزيمة على إمضاء حكمه، وإنفاذاً لمقادير حتمه.
فرأى الأمم فرقاً في أديانها، عكّفاً على نيرانها، عابدة لأوثانها، منكرة لله مع عرفانها(٤) ؛ فأنار الله بأبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ظُلَمها(٥) ، وكشف عن القلوب بُهَمَها(٦) ، وجلّى عن الأبصار غُمَمَها(٧) ، وقام في الناس بالهداية، فأنقذهم من الغواية، وبصّرهم من العماية، وهداهم إلى الدين القويم، ودعاهم إلى الطريق المستقيم.
ثمّ قبضه الله إليه قبض رأفة واختيار، ورغبة وإيثار. فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ تعب
____________________
١ - الذود: الطرد والدفع.
٢ - حاش الإبل: جمعها وساقه.
٣ - المآل: المرجع. والمراد في المقام أنّ الله (عزّ وجلّ) عالم بعواقب الأمور وما تنتهي إليها.
٤ - يعني: إنّهم ينكرون الله (عزّ وجلّ) مع إنّهم بفطرتهم يقرون به وبقدرته.
٥ - الظلم بضم الظاء وفتح اللام: جمع ظلمة.
٦ - البهم بضم الباء وفتح الهاء: مشكلات الأمور.
٧ - الغمم بضم الغين وفتح الميم: جمع غمة. كلّ شيء يستر شيء.
هذه الدار في راحة، قد حفّ بالملائكة الأبرار، ورضوان الربّ الغفّار، ومجاورة الملك الجبّار، صلّى الله على أبي نبيّه وأمينه، وخِيَرته من الخلق وصفيّه، والسّلام عليه ورحمة الله وبركاته».
ثمّ التفتت إلى أهل المجلس وقالت: «أنتم عباد الله نصب أمره ونهيه، وحملة دينه ووحيه، وأمناء الله على أنفسكم، وبلغاؤه إلى الأمم. زعيم حق له فيكم(١) ، وعهد قدمه إليكم، وبقيّة استخلفها عليكم: كتاب الله الناطق، والقرآن الصادق، والنور الساطع، والضياء اللامع. بيّنة بصائره، منكشفة سرائره، منجلية ظواهره، مغتبطة به أشياعه، قائداً إلى الرضوان أتباعه، مؤدٍّ إلى النجاة استماعه. به تنال حجج الله المنوّرة، وعزائمه المفسّرة، ومحارمه المحذّرة، وبيناته الجالية، وبراهينه الكافية، وفضائله المندوبة، ورخصه الموهوبة، وشرائعه المكتوبة.
فجعل الله الإيمان تطهيراً لكم من الشرك، والصلاة تنزيهاً لكم عن الكِبر، والزكاة تزكية للنفس، ونماءً في الرزق، والصيام تثبيتاً للإخلاص، والحج تشييداً للدين، والعدل تنسيقاً للقلوب، وطاعتنا نظاماً للملّة، وإمامتنا أماناً للفرقة، والجهاد عزّاً للإسلام، والصبر معونة على استيجاب الأجر، والأمر بالمعروف مصلحة للعامة، وبرّ الوالدين وقاية من السخط، وصلة الأرحام منسأة في العمر، ومنماة للعدد(٢) ، والقصاص حقناً للدماء، والوفاء بالنذر تعريضاً للمغفرة، وتوفية المكائيل والموازين تغييراً للبخس، والنهي عن شرب الخمر تنزيهاً عن الرجس، واجتناب القذف حجاباً عن اللعنة، وترك السرقة إيجاباً بالعفّة، وحرّم الله الشرك إخلاصاً له بالربوبية؛ فاتقوا الله حق
____________________
١ - الزعيم في المقام الكفيل. والمراد أنّ القرآن المجيد وثيقة الحقّ التي تركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أُمّته.
٢ - يعني: سبباً لطول العمر ونماء العدد وكثرة النسل.
تقاته، ولا تموتنّ إلّا وأنتم مسلمون، وأطيعوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه؛ فإنّه( إنّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء ) ».
ثمّ قالت: «أيّها الناس، اعلموا إنّي فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول عوداً وبدواً، ولا أقول ما أقول غلطاً، ولا أفعل ما أفعل شططاً،( قَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ) . فإنّ تعزوه(١) وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم، وأخا ابن عمّي دون رجالكم. ولنِعْمَ المعزّى إليه صلّى الله عليه وآله وسلم. فبلغ الرسالة صادعاً بالنذارة، مائلاً عن مدرجة المشركين(٢) ضارباً ثبجهم(٣) آخذاً بأكظامهم(٤) ، داعياً إلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة، يكسر [يجذ] الأصنام، وينكث الهام حتى انهزم الجمع وولّوا الدبر. حتى تفرّى الليل عن صبحه(٥) وأسفر الحقّ عن محضه(٦) ، ونطق زعيم الدين، وخرست شقاشق(٧) الشياطين، وطاح وشيظ(٨) النفاق، وانحلّت عقد الكفر والشقاق، وفهتم بكلمة الإخلاص(٩) في نفر من البيض الخماص(١٠) .
____________________
١ - يعني: تنسبوه في أهله.
٢ - يعني: عن مسلك المشركين وطريقتهم.
٣ - الثبج من كلّ شيء وسطه أو أعلاه.
٤ - الأكظام جمع كظَم، وهو مخرج النفس. وذلك كناية عن أنّه صلى الله عليه وآله وسلم أحرج المشركين وضيق عليهم.
٥ - يعني: انقشع ظلام الكفر والباطل وتجلّى نور الحقّ والإيمان.
٦ - يعني: اتضح الحقّ محضاً من دون لبس بباطل.
٧ - شقشق الجمل هدر، والطير صوّت.
٨ - الوشيظ التاج أو الحلف. والمراد هنا سقوط دعوة النفاق وانهيارها وخمودها.
٩ - يعني: نطقتم بكلمة التوحيد.
١٠ - وهم النبي وأهل بيته (صلوات الله عليهم). وفيه إشارة إلى أنّهم (عليهم السّلام) أهل دعوة التوحيد وحملته، وباقي المسلمين تبع لهم فيه، وهو المناسب لاقتصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المباهلة على نفسه الشريفة وأهل بيته من دون أن يدخل معهم غيرهم من المسلمين مهما كان شأنهم في الدين والتقوى، كما يناسبه أيضاً =
وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب(١) ونُهزة الطامع(٢) وقبسة العجلان(٣) ، وموطئ الأقدام، تشربون الطرق(٤) ، وتقتاتون القد(٥) ، أذلّة خاسئين، تخافون أن يتخطّفكم الناس من حولكم؛ فأنقذكم الله تبارك وتعالى بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، بعد اللتيا والتي، وبعد أن مُني ببُهَم(٦) الرجال وذؤبان العرب، ومرَدَة أهل الكتاب.( كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَاراً لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللهُ ) (٧) ، أو نجم قرن الشيطان، أو فغرت فاغرة من المشركين قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ جناحها بأخمصه(٨) ويخمد لهبها بسيفه، مكدوداً في ذات الله، مجتهداً في أمر الله، قريباً من رسول الله، سيّداً في أولياء الله، مشمّراً ناصحاً، مُجدّاً كادحاً(٩) ، لا تأخذه في الله لومة لائم.
وأنتم في رفاهية من العيش، وادعون فاكهون آمنون، تتربّصون بنا الدوائر(١٠) ، وتتوكّفون الأخبار(١١) ، وتنكصون عند النزال، وتفرّون من القتال.
____________________
= قول أمير المؤمنين (عليه السّلام) في كتابه إلى معاوية: «فإنّا صنائع ربّنا، والناس بعد صنائع لنا».
١ - المذقة اللبن الممزوج بالماء، شبهتهم (عليه السّلام) بها لأنّها رديئة.
٢ - النهزة بضم النون الأمر المعرض لأن يغتنم من دون أن يكون له قوّة يمتنع بها.
٣ - القبسة هي الأخذ من النار. وقد شبهتهم (عليها السّلام) بذلك؛ لعدم القوّة والمنعة فيهم، فيأخذ منهم العجلان من دون حاجة إلى تروٍ وإعداد.
٤ - الطرق بسكون الراء: الماء المجتمع الذي يخاض فيه ويبال ويبعر، فيصير كدِر.
٥ - القَد بفتح القاف جلد السخلة. وقد ورد أنّهم كانوا يأكلونه لشدّة حاجتهم وجهدهم.
٦ - جمع بهمة بضم الباء الشجاع. وقيل هو الفارس الذي لا يدرى من أين يؤتى له من شدّة بأسه.
٧ - سورة المائدة/٦٤.
٨ - أخمص القدم ما يرتفع من وسطها فلا يصيب الأرض. وفي بعض طرق الخطبة: «حتى يطأ صماخها بأخمصه» والصماخ وسط الرأس من جهة الأذن.
٩ - الكادح الذي يجهد نفسه وينهكها في سبيل مقصوده وتحقيق مراده.
١٠ - يعني: تنتظرون أن تدور علينا الدوائر وتنزل بنا المصائب.
١١ - يعني: تتوقّعون الأخبار وتنتظرونها.
فلمّا اختار الله لنبيّه دار أنبيائه، ومأوى أصفيائه، ظهر فيكم حسكة(١) النفاق، وسمل جلباب الدين(٢) ، ونطق كاظم الغاوين(٣) ، ونبغ خامل الآقلين(٤) ، وهدر فنيق المبطلين(٥) ، فخطر(٦) في عرصاتكم، وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه(٧) هاتفاً بكم، فألفاكم لدعوته مستجيبين، وللعزّة فيه ملاحظين(٨) ، ثمّ استنهضكم فوجدكم خفافاً، وأحشمكم فألفاكم غضاباً(٩) ؛ فوسمتم غير إبلكم(١٠) ، ووردتم غير مشربكم(١١) .
هذا والعهد(١٢) قريب، والكلم رحيب(١٣) ، والجرح لما
____________________
١ - الحسك والحسكة والحسيكة الحقد، تشبيهاً بنبات الحسك.
٢ - سمل بمعنى صار خلِق. والجلباب نوع من الثياب، وأضيف للدين على نحو التشبيه. نظير قوله تعالى:( قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير ) (سورة الأعراف/٢٦). ومرادها (عليها السّلام) أنّ الدين قد ضعف أثره فيهم.
٣ - الكاظم هو الحابس صوته. ومرادها (عليها السّلام) أنّ الغواة نطقوا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن كانوا قد اضطروا للسكوت في حياته.
٤ - يعني: إنّ الخاملين الذين لا شأن لهم قد رفعوا رؤوسهم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
٥ - هدر البعير ردّد صوته في حنجرته، والفنيق هو الفحل الذي لا يركب لكرامته على أهله.
٦ - خطر في مشيته سار معجباً بنفسه يرفع يديه ويضعهم.
٧ - كأنّها (عليها السّلام) تشبه الشيطان بالقنفذ الذي يخفي رأسه في بدنه عند الخوف، فإذا ذهب الخوف أطلع رأسه، وكذلك حال الشيطان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
٨ - يعني: تنظرون لأسباب العزّ التي يسوّل بها الشيطان، وتنتهزون الفرصة من أجله.
٩ - أحشمه: هيجه وأغضبه. وكأنّها (عليها السّلام) تريد أنّ الشيطان هيجهم واختبرهم فوجدهم قد فقدوا أحلامهم ورشدهم، فخفوا لطلب الدنيا يغضبون له، وينعطفون إليه.
١٠ - وسم الحيوان: كواه. وكانوا يفعلون به ذلك؛ ليتميز به على أنّه ملكه.
١١ - يعني: أنّكم أتيتم إلى ماء ليس بماء لكم فشربتم منه. وأرادت (عليها السّلام) بهاتين الفقرتين الكناية عن غصبهم للخلافة، وسلبها من أهلها، وهم أهل البيت (عليهم السّلام).
١٢ - لا يبعد كون مرادها (عليها السّلام) أنّ العهد الذي أخذ عليهم من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في أمر الخلافة قريب، لم يبعد أمده؛ كي يمكن الغفلة عنه ونسيانه.
١٣ - الكلم: الجرح، والرحيب من الرحب، وهو السعة، وكأنّ مرادها (عليها السّلام) أنّ جرح الإسلام وأهل البيت (عليهم السّلام) =
يندمل(١) ، والرسول لما يُقبر. ابتداراً زعمتم(٢) خوف الفتنة.( أَلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ) (٣) .
فهيهات منكم، وكيف بكم، وأنّى تؤفكون(٤) ، وكتاب الله بين أظهركم، أموره ظاهرة، وأحكامه زاهرة، وأعلامه باهرة، وزواجره لايحة، وأوامره واضحة، وقد خلفتموه وراء ظهوركم. أرغبة عنه تريدون؟ أم بغيره تحكمون؟( بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلا ) (٥) ،( وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) (٦) .
ثمّ لم تلبثوا إلّا ريث أن تسكن نفرتها ويسلس قيادها(٧) ، ثمّ أخذتم تورون وقدتها وتهيجون جمرتها(٨) ، وتستجيبون لهتاف الشيطان الغوي، وإطفاء أنوار الدين الجلي، وإهمال سنن النبي الصفي، تشربون حسواً في ارتغاء(٩) ، وتمشون
____________________
= بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واسع عميق.
١ - يعني: إنّ الجرح بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبرأ بعد، ولم ينس المصاب به صلى الله عليه وآله وسلم.
٢ - تعريض باعتذارهم عن الإسراع في أمر الخلافة وفي بيعة الخليفة بخوف الفتنة بين المسلمين وانشقاقهم على أنفسهم.
٣ - سورة التوبة/٤٩.
٤ - يعني: تصرفون. وكأنّها (عليها السّلام) بذلك تنذرهم بخطر ما فيه وضرره، وأنّه هيهات أن يقبل منهم عذر، وكيف يكون حالهم وإلى أين صرفهم الشيطان والحال أنّ الكتاب المجيد بين أظهرهم قد أوضح الحقّ وألزمهم به.
٥ - سورة الكهف/٥٠.
٦ - سورة آل عمران/٨٥.
٧ - يعني: سهل عليهم إدارة أمور الخلافة وقيادة الأمور. وقد أشارت (عليها السّلام) بذلك إلى أنّهم بعد أن استولوا على الخلافة واستتبّت لهم الأمور سارعوا إلى العدوان على أهل البيت (عليهم السّلام) بغصب حقوقهم في فدك والميراث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره.
٨ - شبّهت (عليها السّلام) مصيبة أهل البيت (عليهم السّلام) بفقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجمرة الكامنة، وكأنّ الاعتداء عليهم بغصب حقوقهم أشعل النار فيها وهيجه، فاشتدّ مصابهم.
٩ - الارتغاء أخذ رغوة اللبن، والحسو منه شرب اللبن نفسه تدريجاً: فهم يظهرون أنّهم يريدون أخذ الرغوة فقط، لكنّهم في الحقيقة يشربون معه اللبن نفسه، وفي بعض الروايات: «تسرون حسواً في ارتغاء». وهو =
لأهله وولده في الخمرة والضرّاء(١) ، ويصير [ونصبر] منكم على مثل حزّ المدى، ووخز السنان في الحشا(٢) .
وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لنا. أفحكم الجاهلية تبغون؟!( وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) (٣) ، أفلا تعلمون؟ بلى، قد تجلّى لكم كالشمس الضاحية إنّي ابنته. أيّها المسلمون أُغلب على إرثي؟!
يابن أبي قحافة، أفي كتاب الله ترث أباك ولا أرث أبي؟ لقد جئت شيئاً فريّاً! أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم؟ إذ يقول:( وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ) (٤) ، وقال: فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا إذ قال:( فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ) (٥) ، وقال:( وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (٦) ، وقال:( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) (٧) ، وقال:( إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ) (٨) .
____________________
= مثل يضرب لمَنْ يظهر شيئاً ويبطن غيره.
١ - الخمر ما واراك من شجر أو غيره، والخمرة كثرة الناس وزحمتهم، أمّا الضرّاء فقد فسّر بالشجر الملتفّ. وعلى ذلك فكأنّها (عليها السّلام) تريد أن أهل البيت (عليهم السّلام) بعد غصب الخلافة قد اعتزلوا الناس واستتروا في بيوتهم وانشغلوا بمصابهم، ولكنّ القوم لم يتركوهم، بل تعقبّوهم وتتبّعوهم بالتعدّي عليهم وإنزال المصائب بهم.
٢ - شبّهت (عليها السّلام) اعتداء القوم على أهل البيت (عليهم السّلام) وإيذائهم لهم بحزّ السكاكين ووخز أسنة الرماح وطعنها في أحشائهم.
٣ - سورة المائدة/٥٠.
٤ - سورة النمل/١٦.
٥ - سورة مريم/٥ - ٦.
٦ - سورة الأنفال/٧٥، وسورة الأحزاب/٦.
٧ - سورة النساء/١١.
٨ - سورة البقرة/١٨٠.
وزعمتم أن لا حظوة لي ولا إرث من أبي، ولا رحم بيننا. أفخصّكم الله بآية أخرج أبي منها؟! أم هل تقولون: إنّا أهل ملّتين لا يتوارثان؟! أو لستُ أنا وأبي من أهل ملّة واحدة؟! أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمّي؟! فدونكها مخطومة مرحولة(١) تلقاك يوم حشرك. فنِعْمَ الحكم الله، والزعيم محمد، والموعد القيامة، وعند الساعة يخسر المبطلون، ولا ينفعكم إذ تندمون، و( لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ) (٢) ( مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ) (٣» ).
ثمّ رمت بطرفها نحو الأنصار فقالت: «يا معشر النقيبة(٤) ، وأعضاد الملّة، وحضنة الإسلام، ما هذه الغَمِيزة(٥) في حقّي والسِنة(٦) عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبي يقول: المرء يُحفظ في ولده؟ سرعان ما أحدثتم، وعجلان ذا إهالة(٧) . ولكم طاقة بما أحاول، وقوّة
____________________
١ - الناقة المخطومة: هي التي يوضع خطامها في أنفها لتقاد به، والمرحولة: هي التي يوضع رحلها عليها، وتُهيّأ للركوب. وقد شبّهت (عليها السّلام) ظلامتها بالناقة الجاهزة للركوب؛ لبيان أنّها جاهزة للشكاية يوم القيامة.
٢ - سورة الأنعام/٦٧.
٣ - سورة الزمر/٤٠.
٤ - النقيب: شاهد القوم وكفيلهم. وقد بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة العقبة على أن يمنعوه وأهله ممّا يمنعون منه أنفسهم وأهليهم. وقد أخرج منهم اثنى عشر نقيباً يكونون شهداء عليهم بذلك. فلعلّها (عليها السّلام) تشير إلى ذلك وتذكّرهم به. وعن بعض النسخ: «يا معشر البقية»، وعن أخرى: «يا معشر الفتية».
٥ - الغميزة ضعف في العمل وجهل في العقل. وعن بعض النسخ: «ما هذه الفترة».
٦ - السُنّة بكسر السين أوّل النوم. وتشير (عليها السّلام) بذلك إلى تقاعسهم عن نصرها في استرجاع حقّه، في محاولة منها لاستنهاضهم.
٧ - المثل المذكور في كلام اللغويين: سرعان ذا إهالة، وفي القاموس: إنّه يُضرب لمَنْ يخبر بكينونة الشيء قبل وقته. ولعلّ المثل في عهدها (عليها السّلام) كان يُقال بالوجهين، أو إنّها (عليها السّلام) أبدلت سرعان بعجلان من أجل أنّ الفقرة السابقة تضمّنت (سرعان). وغرضها (عليها السّلام) الإنكار على الأنصار في سرعة تبدّل موقفهم إزاء ما يجب عليهم نتيجة إسلامهم والعهد المأخوذ عليهم.
على ما أطلب وأزاول.
أتقولون مات محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فخطب جليل، استوسع وهنه(١) ، واستنهر فتقه(٢) ، وانفتق رتقه(٣) ، وأظلمت الأرض لغيبته، وكُسفت الشمس والقمر، وانتثرت النجوم لمصيبته، وأكدت الآمال(٤) ، وخشعت الجبال، وأضيع الحريم، وأزيلت الحرمة عند مماته(٥) .
فتلك والله النازلة الكبرى، والمصيبة العظمى، لا مثلها نازلة، ولا بائقة(٦) عاجلة، أعلن بها كتاب الله (جلّ ثناؤه) في أفنيتكم، وفي ممساكم ومصبحكم، يهتف في أفنيتكم(٧) هتاف، وصراخ، وتلاوة، وألحان. ولقبله ما حلَّ بأنبياء الله ورسله، حكم فصل، وقضاء حتم( وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ فإنّ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ ) (٨) .
إيهاً بني قيلة(٩) أأُهضم تراث أبي؟ وأنتم بمرأى منّي ومسمع، ومنتدى(١٠)
____________________
١ - استوسع يعني: اتسع، والوهن الضعف. وكأنّها (عليها السّلام) تريد أنّ موته صلى الله عليه وآله وسلم أوجب سريان الضعف في أُمّته. وقد تقرأ: وهيه، من الوهي وهو الشق والخرق.
٢ - استنهر الفتق اتسع.
٣ - رتق الفتق أصلحه، ورتق فتق القوم أصلح ذات بينهم. وكأنّها (عليها السّلام) تريد أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سعى جاهداً لرتق فتق قومه وإصلاح أمرهم، وبموته انفتق رتقه، ورجعوا إلى ما كانوا عليه من الفساد والانشقاق.
٤ - أكدى الرجل: بخل، وأكدى العام: أجدب. وهو في المقام كناية عن خيبة الآمال.
٥ - كأنّها (عليها السّلام) تشير إلى انتهاك حرمة أهل البيت (عليهم السّلام) بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
٦ - البائقة الداهية الشديدة.
٧ - الأفنية جمع فناء بالكسر، وهو الساحة أمام البيت.
٨ - سورة آل عمران/١٤٤.
٩ - قال في لسان العرب: وقَيلة أُمّ الأوس والخزرج. وفي حديث سلمان: ابني قيلة. يريد الأوس والخزرج قبيلتي الأنصار. وقيلة اسم أُمّ لهم قديمة. وهي قيلة بنت كاهل.
١٠ - المنتدى: مجلس القوم ومتحدثهم.
ومجمع، تلبسكم الدعوة(١) ، وتشملكم الخبرة(٢) وأنتم ذوو العدد والعدّة، والأداة والقوّة، وعندكم السلاح والجنّة(٣) . توافيكم الدعوة فلا تجيبون، وتأتيكم الصرخة فلا تغيثون وأنتم موصوفون بالكفاح، معروفون بالخير والصلاح، والنخبة التي انتخبت، والخيرة التي اختيرت لنا أهل البيت. قاتلتم العرب، وتحملتم الكدّ والتعب، وناطحتم الأُمم، وكافحتم البهم(٤) ، لا نبرح أو تبرحون(٥) نأمركم فتأتمرون حتى إذا دارت بنا رحى الإسلام، ودرّ حلب الأيام، وخضعت ثغرة الشرك(٦) ، وسكنت فورة الإفك، وخمدت نيران الكفر، وهدأت دعوة الهرج، واستوسق نظام الدين.
فأنى حزتم بعد البيان؟(٧) ، وأسررتم بعد الإعلان؟(٨) ، ونكصتم بعد الإقدام؟ وأشركتم بعد الإيمان؟ بؤساً لقوم نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم،( وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ) (٩) .
____________________
١ - شبّهت (عليها السّلام) دعوتها لهم من أجل الانتصار لها بالثوب الملبوس الشامل لجميع البدن؛ لبيان أنّ دعوتها قد وصلت إليهم جميعاً.
٢ - الخبرة بالضم العلم بالشيء على حقيقته.
٣ - الجنة بضم الجيم كلّ ما وقى من السلاح.
٤ - جمع بهمة بضم الباء: الشجاع. وقد تقدّم ذكره بتفصيل.
٥ - وفي بعض طرق الخطبة: «لا نبرح وتبرحون». ولعلّه الأنسب.
٦ - الثغرة بضم الثاء نقرة النحر في أصل الرقبة، وفي ذلك تشبيه للشرك بالإنسان الذي ينحني خضوعاً واستسلاماً لعدوه.
٧ - الحوز: ضم الشيء وجمعه. وكأنّه كناية عن الاستئثار بالشيء تعدّياً. وفي نسخة أخرى: (حرتم) بالمهملتين وضم الحاء بمعنى الرجوع والنكوص، أو كسرها بمعنى التحيّر والتردّد في المواقف. وفي نسخة ثالثة: (جرتم) بالجيم من الجور والميل عن الحقّ. وهما أنسب.
٨ - الظاهر أنّه كناية عن كتمان الحقّ والجبن عن الإعلان به.
٩ - سورة التوبة/١٣.
ألا وقد أرى أن قد أخلدتم إلى الخفض(١) ، وأبعدتم مَنْ هو أحق بالبسط والقبض(٢) ، وخلوتم بالدعة(٣) ، ونجوتم بالضيق من السعة(٤) ، فمججتم ما وعيتم(٥) ، ودسعتم الذي تسوّغتم(٦) ، فـ( إِن تَكْفُرُواْ أَنتُمْ وَمَن فِي الأَرْضِ جَمِيعاً فإنّ اللهَ لَغَنِيٌّ حَمِيد ) (٧) ، ألا وقد قلت ما قلت هذا على معرفة منّي بالجذلة التي خامرتكم(٨) ، والغدرة التي استشعرتها قلوبكم، ولكنّها فيضة النفس، ونفثة الغيظ، وخور القناة(٩) ، وبثة الصدر، وتقدمة الحجّة.
____________________
١ - يعني: ركنتم إلى لين العيش وسعته، بدلاً من متاعب الجهاد وإنكار المنكر.
٢ - تريد (عليها السّلام) إبعادهم أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) عن الخلافة وإدارة أمور المسلمين.
٣ - خلا بالشيء: انفرد به ولم يخلط به غيره. والدعة الراحة والسكون وخفض العيش.
٤ - النجاء الخلاص والإسراع. وعليه يتعيّن كون المراد بالضيق ضيق المسؤولية الإلهية؛ نتيجة التقصير في أداء الواجب، وبالسعة الثواب الإلهي؛ نتيجة أداء الواجب، فيرجع إلى أنّهم استبدلوا سخط الله تعالى برضاه. وفي بعض النسخ: «ونجوتم من الضيق بالسعة» فيكون المراد بالضيق ضيق الجهاد وكلفته، وبالسعة الراحة في ترك الجهاد.
٥ - مج الماء من فمه رمى به. وتشبيهاً بذلك يُقال: هذا كلام تمجّه الأسماع، أي تنفر منه. ووعى الحديث قبله وتدبّره وحفظه، وعلى ذلك يكون مرادها (عليها السّلام) أنّهم رفضوا ما قبلوه سابقاً من التعاليم الدينية القاضية بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
٦ - الدسع في المقام القيء. شبّهت (عليها السّلام) رفضهم لِما قبلوه من تعاليم الدين بتركهم نصرها بمَنْ قاء الشراب بعد أن تسوّغه.
٧ - سورة إبراهيم/٨.
٨ - خامرتكم يعني خالطتكم واستترت في نفوسكم. والجذلة من الجذل بالجيم والذال المعجمة من الفرح. ولا يتّضح وجه إرادتها في المقام، ومن هنا كان الظاهر أنّ الصحيح ما في نسخة أُخرى من قولها (عليها السّلام): «والخذلة التي خامرتكم» بالخاء والذال المعجمتين من الخذلان؛ حيث يتّضح المعنى المراد حينئذٍ.
٩ - الخور الضعف، والقناة الرمح. وهو كناية عن ضعفها (عليها السّلام) عن كتمان غضبها وغيضها على غرار الفقرتين السابقتين والفقرة اللاحقة؛ حيث يؤكّد بعضها بعضاً. أمّا الفقرة الخامسة، وهي تقدمة الحجّة فهي تتضمّن غرضاً آخر له أهميته في المقام.
فدونكموها فاحتقبوها(١) دبرة الظهر(٢) ، نقبة الخف(٣) ، باقية العار، موسومة بغضب الجبّار، وشنار(٤) لا بدّ موصولة بنار الله الموقدة،( الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ) (٥) ، فبعين الله ما تفعلون( وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ) (٦) . وأنا ابنة نذير لكم بين يدي عذاب شديد فاعملوا إنّا عاملون،( وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ ) (٧) ».
____________________
١ - الحقب الحزام الذي يلي حقو البعير. واحتقب فلان الإثم كأنّه جمعه واحتقبه من خلفه. وكأنّها (عليها السّلام) تشبه تحملهم مسؤولية ما حصل بمَنْ يشدّ حزام الناقة ويهيؤها ليغصبه.
٢ - يعني: أصابها الدبرة، وهي قرحة في ظهر الناقة من الرحل ونحوه.
٣ - يعني: رق خفه، لجهد أصابه.
٤ - الشنار: العار.
٥ - سورة الهمزة/٧.
٦ - سورة الشعراء/٢٢٧.
٧ - سورة هود/١٢٢.
مصادر الخطبة
وردت هذه الخطبة في مصادر كثيرة:
١- قال ابن طيفور أحمد بن أبي طاهر: حدّثني جعفر بن محمد - رجل من أهل ديار مصر لقيته بالرافقة - قال: حدّثني أبي، قال: أخبرنا موسى بن عيسى، قال: أخبرنا عبد الله بن يونس، قال: أخبرنا جعفر الأحمر، عن زيد بن علي (رحمة الله عليه)، عن عمّته زينب بنت الحسين (عليهما السّلام)، قالت: لما بلغ فاطمة (عليها السّلام) إجماع أبي بكر على منعها فدك لاثت خمارها...(١) .
وقال أيضاً: قال أبو الفضل: ذكرت لأبي الحسين زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) كلام فاطمة (عليها السّلام) عند منع أبي بكر إيّاها فدك، وقلت له: إنّ هؤلاء يزعمون أنّه مصنوع، وإنّه من كلام أبي العيناء (الخبر منسوق البلاغة على الكلام).
فقال لي: رأيت مشايخ آل أبي طالب يروونه عن آبائهم، ويعلّمونه أبناءهم، وقد حدّثنيه أبي عن جدّي يبلغ به فاطمة على هذه الحكاية. ورواه مشايخ الشيعة وتدارسوه بينهم قبل أن يولد جدّ أبي العيناء. وقد حدّث به الحسن بن علوان عن عطية العوفي أنّه سمع عبد الله بن الحسن يذكره عن أبيه...(٢) .
٢- قال الخوارزمي: وأخبرني الإمام شهاب الإسلام أبو النجيب سعد بن عبد الله الهمداني فيما كتب إليّ من همدان، أخبرني الحافظ سليمان بن إبراهيم فيما كتب إليّ من أصبهان سنة ثمان وثمانين وأربعمئة، أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه فيما أذن لي، قال: حدّثت جعفر بن محمد بن مروان، أخبرنا أبي، أخبرنا سعيد بن محمد الجرمي، أخبرنا عمرو بن ثابت عن
____________________
١ - بلاغات النساء/١٤ وما بعده، كلام فاطمة وخطبه.
٢ - بلاغات النساء/١٢ كلام فاطمة وخطبه.
أبيه، عن حبّة، عن علي (عليه السّلام)....
وبهذا الإسناد عن الحافظ أبي بكر هذا، أخبرنا عبد الله بن إسحاق، أخبرنا محمد بن عبيد، أخبرنا محمد بن زياد، أخبرنا شرقي بن قطامي، عن صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أنّها قالت: لما بلغ فاطمة أنّ أبا بكر...(١) .
٣- قال ابن أبي الحديد في ذكر ما ورد من السير والأخبار في أمر فدك: الفصل الأوّل: في ما ورد من الأخبار والسير المنقولة من أفواه أهل الحديث وكتبهم، لا من كتب الشيعة ورجالهم؛ لأنّا مشترطون على أنفسنا ألاّ نحفل بذلك.
وجميع ما نورده في هذا الفصل من كتاب أبى بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في السقيفة وفدك، وما وقع من الاختلاف والاضطراب عقب وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأبو بكر الجوهري هذا عالم محدّث كثير الأدب، ثقة ورع، أثنى عليه المحدّثون، ورووا عنه مصنّفاته....
قال أبو بكر: فحدّثني محمد بن زكريا، قال: حدّثني جعفر بن محمد بن عمارة الكندي، قال: حدّثني أبي، عن الحسين بن صالح بن حي، قال: حدّثني رجلان من بني هاشم، عن زينب بنت علي بن أبي طالب (عليه السّلام).
قال: وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه.
قال أبو بكر: وحدّثني عثمان بن عمران العجيفي، عن نائل بن نجيح بن عمير بن شمر، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر محمد بن علي (عليه السّلام).
قال أبو بكر: وحدّثني أحمد بن محمد بن يزيد، عن عبد الله بن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن عبد الله بن حسن بن الحسن.
____________________
١ - مقتل الحسين ١/٧٧ - ٧٨ الفصل الخامس في فضائل فاطمة الزهراء (عليها السّلام).
قالوا جميعاً: لما بلغ فاطمة (عليها السّلام) إجماع أبي بكر على منعها فدك، لاثت خمارها...(١) .
٤- قال الأربلي(٢) عند ذكره لهذه الخطبة: ونقلتها من كتاب السقيفة عن عمر بن شبه تأليف أبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري من نسخة قديمة مقروءة على مؤلّفها المذكور: قرئت عليه في ربيع الآخر سنة اثنتين وعشرين وثلثمئة روى عن رجاله من عدّة طرق أنّ فاطمة (عليها السّلام) لما بلغها إجماع أبي بكر على منعها فدكاً لاثت خمارها....
٥- وقد أوردها جماعة كاملة من دون ذكر السند، كأبي سعد منصور بن الحسين الآبي(٣) ، وابن حمدون(٤) ، وابن الدمشقي(٥) كما أشار إليها المسعودي(٦) .
٦- وروى الصدوق بعضها بعدّة أسانيد قال: حدّثنا محمد بن موسى بن المتوكّل (رضي الله عنه)، قال: حدّثنا علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن عبد الله البرقي، عن إسماعيل بن مهران، عن أحمد بن محمد بن جابر، عن زينب بنت علي، قالت: قالت فاطمة (عليها السّلام) في خطبته....
أخبرني علي بن حاتم، قال: حدّثنا محمد بن أسلم، قال: حدّثني عبد الجليل الباقلاني، قال: حدّثني الحسن بن موسى الخشاب، قال: حدّثني عبد الله بن محمد العلوي، عن رجال من أهل بيته، عن زينب بنت علي، عن
____________________
١ - شرح نهج البلاغة ١٦/٢١١.
٢ - كشف الغمة ٢/١٠٨ وما بعده.
٣ - نثر الدر ٤/٥ وما بعدها الباب الأوّل كلام للنساء الشرائف، فاطمة ابنة رسول الله (عليها السّلام) خطبتها لما منعها أبو بكر فدكاً.
٤ - التذكرة الحمدونية ٢/٢٣١ الباب الثلاثون في الخطب.
٥ - جواهر المطالب في مناقب الإمام علي (عليه السّلام) ١/١٥٦ وما بعده.
٦ - مروج الذهب ٢/٣٠٥ باب ذكر خلافة أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) قبل خاتمة الباب بأسطر.
فاطمة (عليها السّلام) بمثله.
وأخبرني علي بن حاتم أيضاً قال: حدّثني محمد بن أبي عمير، قال: حدّثني محمد بن عمارة قال: حدّثني محمد بن إبراهيم المصري، قال: حدّثني هارون بن يحيى الناشب، قال: حدّثنا عبيد الله بن موسى العبسي، عن عبيد الله بن موسى العمري، عن حفص الأحمر، عن زيد بن علي، عن عمّته زينب بنت علي، عن فاطمة (عليها السّلام) بمثله، وزاد بعضهم على بعض في اللفظ(١) .
٧- قال السيد المرتضى: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني، قال: حدّثني محمد بن أحمد الكاتب، حدّثنا أحمد بن عبيد بن ناصح النحوي، قال: حدّثنا الزيادي، قال: حدّثنا الشرقي بن القطامي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدّثنا صالح بن كيسان، عن عروة، عن عائشة.
قال المرزباني: وحدّثنا أبو بكر أحمد بن محمد المكي، قال: حدّثنا أبو العينا محمد بن القاسم السيمامي، قال: حدّثنا ابن عائشة، قال: لما قُبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقبلت فاطمة (عليها السّلام) في لمّة من حفدتها إلى أبي بكر.
وفي الرواية الأولى قالت عائشة: لما سمعت فاطمة (عليها السّلام) إجماع أبي بكر على منعها فدكاً لاثت خمارها على رأسها، واشتملت بجلبابها، وأقبلت في لمّة من حفدتها ثمّ اجتمعت الروايتان من...(٢) .
وقال السيد المرتضى في وسط الخطبة: أو قالت: ويخمد لهبهتا بحدّه مكدوداً في ذات الله وأنتم في رفاهية، فكهون آمنون وادعون. إلى هاهنا انتهى خبر أبي العيناء، عن ابن عائشة، وزاد عروة بن الزبير، عن عائشة...(٣) .
____________________
١ - علل الشرائع ١/٢٤٨.
٢ - الشافي في الإمامة ٤/٦٩ - ٧١.
٣ - الشافي في الإمامة ٤/٧٣ - ٧٤.
وقال السيد المرتضى: وأخبرنا أبو عبد الله المرزباني، قال: حدّثني علي بن هارون، قال: أخبرني عبد الله بن أحمد بن أبي طاهر، عن أبيه، قال: ذكرت لأبي الحسين زيد بن علي بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن زيد بن علي كلام فاطمة (عليها السّلام) عند منع أبي بكر إيّاها فدكاً.
وقلت له: إنّ هؤلاء يزعمون أنّه مصنوع، وإنّه كلام أبي العيناء؛ لأنّ الكلام منسوق البلاغة. فقال لي: رأيت مشائخ آل أبي طالب يروونه عن آبائهم... إلى آخر ما تقدّم في كلام ابن طيفور(١) .
٨- قال الطبري الإمامي: حدّثني أبو المفضل محمد بن عبد الله، قال: حدّثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن عثمان بن سعيد الزيات، قال: حدّثنا محمد بن الحسين القصباني، قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي السكوني، عن أبان بن عثمان الأحمر، عن أبان بن تغلب الربعي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لما بلغ فاطمة (عليها السّلام) إجماع أبي بكر على منع فدكاً....
وقال أيضاً: وأخبرني أبو الحسين محمد بن هارون بن موسى التلعكبري، قال: حدّثنا أبي (رضي الله عنه)، قال: حدّثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، قال: حدّثني محمد بن المفضل بن إبراهيم بن المفضل بن قيس الأشعري، قال: حدّثنا علي بن حسان، عن عمّه عبد الرحمان بن كثير، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليه السّلام)، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن عمّته زينب بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهم السّلام)، قالت: لما أجمع أبو بكر على منع فاطمة (عليها السّلام) فدكاً....
وقال أبو العباس: وحدّثنا محمد بن المفضل بن إبراهيم الأشعري، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن عمرو بن عثمان الجعفي، قال: حدّثني
____________________
١ - الشافي في الإمامة ٤/٧٦ - ٧٨.
أبي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن عمّته زينب بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) وغير واحد، من أنّ فاطمة لما أجمع أبو بكر على منعها فدكاً....
وقال أيضاً: وحدّثني القاضي أبو إسحاق إبراهيم بن مخلد بن جعفر بن مخلد بن سهل بن حمران الدقاق، قال: حدّثتني أم الفضل خديجة بنت محمد بن أحمد بن أبي الثلج، قالت: حدّثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد الصفواني، قال: حدّثنا أبو أحمد عبد العزيز بن يحيى الجلودي البصري، قال: حدّثنا محمد بن زكريا، قال: حدّثنا جعفر بن محمد بن عمارة الكندي، قال: حدّثني أبي عن الحسن بن صالح بن حي - قال: وما رأت عيناي مثله - قال: حدّثني رجلان من بني هاشم، عن زينب بنت علي (عليهما السّلام)، قالت: لما بلغ فاطمة إجماع أبي بكر على منع فدك، وانصراف وكيلها عنه، لاثت خمارها... وذكر الحديث.
قال الصفواني: وحدّثني محمد بن محمد بن يزيد مولى بني هاشم، قال: حدّثني عبد الله بن محمد بن سليمان، عن عبد الله بن الحسن بن الحسن، عن جماعة من أهله... وذكر الحديث.
قال الصفواني: وحدّثني أبي، عن عثمان، قال: حدّثنا نائل بن نجيح، عن عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر (عليه السّلام)... وذكر الحديث.
قال الصفواني: وحدّثنا عبد الله بن الضحاك، قال: حدّثنا هشام بن محمد، عن أبيه وعوانة.
قال الصفواني: وحدّثنا ابن عائشة ببعضه. وحدّثنا العباس بن بكار، قال: حدّثنا حرب بن ميمون، عن زيد بن علي، عن آبائه (عليهم السّلام) قالوا: لما بلغ فاطمة (عليها السّلام)
إجماع أبي بكر على منعها فدكاً...(١) .
٩- قال السيد ابن طاووس: ما ذكره الشيخ أسعد بن سقروة في كتاب الفائق، عن الأربعين، عن الشيخ المعظم عندهم، الحافظ الثقة بينهم، أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصفهاني في كتاب المناقب، قال: أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن إبراهيم، قال: حدّثنا أحمد بن عبيد بن ناصح النحوي، قال: حدّثنا الزيادي محمد بن زياد، قال: حدّثنا شرفي بن قطامي، عن صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أنّها قالت: لما بلغ فاطمة (عليها السّلام) أنّ أبا بكر قد أظهر منعها فدكاً لاثت خمارها...(٢) .
١٠- أوردها عمر رضا كحالة من دون ذكر السند(٣) .
____________________
١ - دلائل الإمامة/١١٢ وما بعده.
٢ - الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف/٢٦٣ - ٢٦٤.
٣ - أعلام النساء ٤/١١٦ - ١٢٩.
ملحق رقم (٢)
خطبة الزهراء (عليها السّلام) الصغرى
قال الطبرسي(١) : قال سويد بن غفلة: لما مرضت فاطمة (سلام الله عليها) المرضة التي توفّيت فيها دخلت عليها نساء المهاجرين والأنصار يعدنها، فقلنَ لها: كيف أصبحت من علّتك يا بنت رسول الله؟
فحمدت الله، وصلّت على أبيها، ثمّ قالت: «أصبحت والله عائفة(٢) لدنياكن، قالية(٣) لرجالكن، لفظتهم بعد أن عجمتهم(٤) ، وسئمتهم بعد أن سبرتهم(٥) ؛ فقبحاً لفلول الحد(٦) ، واللعب بعد الجد، وقرع الصفاة(٧) ، وصدع القناة(٨) ، وختل(٩) الآراء وزلل الأهواء، وبئس
____________________
١ - الاحتجاج ١/١٤٦ - ١٤٩.
٢ - عاف الشيء: كرهه فتركه.
٣ - قلى الشيء: أبغضه.
٤ - لفظ الشيء: رمى به. وعجم الشيء: اختبره وامتحنه. ومرادها (عليها السّلام) الكناية عن بغضها لرجالهنّ بعد أن اختبرتهم ورأت سوء مواقفهم وأعمالهم.
٥ - يعني: اختبرتهم وامتحنتهم.
٦ - الفلول جمع فل: الكسر أو الثلمة في حدّ السيف. وهو يوجب وهنه، كما وهن رجال المهاجرين والأنصار إزاء واجبهم في أمر الخلافة.
٧ - القرع: الضرب. والصفاة: الحجر الصلد الضخم. وكأنها (عليه السّلام) تشير إلى عدم الفائدة في قرع الحجر الصلد، كما لا يؤثر التقريع في الرجال المذكورين، لقسوة قلوبهم.
٨ - القناة: الرمح. والصَدع: الشق في الشيء الصلب. وهي (عليها السّلام) بذلك تشير إلى أنّ انشقاق عود الرمح يوجب سقوطه عن أن ينتفع به، كما هو حال الرجال المذكورين.
٩ أ الختل: الخدع.
ما قدمت لهم أنفسهم( أَن سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ) (١) .
لا جرم(٢) لقد قلّدتهم ربقتها(٣) ، وحملتهم أوقتها(٤) ، وشننت عليهم غاراتها(٥) ، فجدعاً(٦) وعقراً(٧) ، و( بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ) (٨) .
ويحهم أنّى زعزعوها(٩) عن رواسي الرسالة، وقواعد النبوّة والدلالة، ومهبط الروح الأمين، والطبين(١٠) بأمور الدنيا والدين؟!( أَلا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ) (١١) .
وما الذي نقموا من أبي الحسن (عليه السّلام)؟! نقموا والله منه نكير سيفه، وقلّة مبالاته لحتفه، وشدّة وطأته، ونكال وقعته، وتنمّره(١٢) في ذات الله.
وتالله لو مالوا عن المحجّة اللائحة، وزالوا عن قبول الحجّة الواضحة، لردّهم إليها، وحملهم عليها، ولسار بهم سيراً سجحاً(١٣) لا يكلم حشاشه(١٤) ، ولا
____________________
١ - سورة المائدة/٨٠.
٢ - عن الفراء أنّه قال: لا جرم كلمة كانت في الأصل بمنزلة لا بدّ ولا محالة، فجرت على ذلك وكثرت حتى تحوّلت إلى معنى القسم، وصارت بمنزلة حقّاً.
٣ - التقليد جعل الشيء في العنق، كالقلادة. والربقة بالكسر: العروة في الحبل. ومرادها (عليها السّلام) أنّها تحمّلهم جريمة نقل الخلافة عن موضعها ومسؤولية ذلك.
٤ - الأوق الثقل. وهذه الفقرة مؤكّدة لمضمون الفقرة السابقة.
٥ - شنّ الغارة عليهم: وجهها من كلّ جهة. ومرادها (عليها السّلام) توجيه اللوم والتبكيت عليهم.
٦ - الجدع: قطع الأنف ونحوه. يُقال: جدعاً لك، أي: جعلك الله معيباً وقطع عنك الخير.
٧ - العقر الجرح ونحوه ممّا يوقع بالشيء ويعيبه. وهذه الفقرة مؤكّدة لمضمون الفقرة السابقة.
٨ - سورة هود/٤٤.
٩ - أي: الخلافة.
١٠ - رجل طبن أي: فطن حاذق عالم بكلّ شيء. ولعلّ الطبين مبالغة في ذلك.
١١ - سورة الزمر/١٥.
١٢ - التنمر: الغضب والشدّة.
١٣ - مشية سحج أي: سهلة.
١٤ - الكلم: الجرح. والحشاش بكسر الحاء المهملة: الجانب من كلّ شيء. وكأنّ المراد أنّ السير سهل بحيث =
يكلّ سائره، ولا يملّ راكبه، ولأوردهم منهلاً(١) نميراً(٢) ، صافي روي، تطفح ضفتاه(٣) ، ولا يترنق جانباه(٤) ، ولأصدرهم بطاناً(٥) ، ونصح لهم سراً وإعلاناً، ولم يكن يتحلّى من الدنيا بطائل، ولا يحظى منها بنائل، غير ريّ الناهل(٦) ، وشبعة الكافل(٧) ، ولبان لهم الزاهد من الراغب، والصادق من الكاذب.
( وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ) (٨) ،( وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاء سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ) (٩) .
ألا هلمّ فاسمع؟! وما عشت أراك الدهر عجباً! وإن تعجب فعجب قولهم!... ليت شعري إلى أيّ أسناد استندوا؟! وإلى أيّ عماد اعتمدوا؟! وبأيّة عروة تمسّكوا؟! وعلى أيّة ذرية أقدموا واحتنكوا(١٠) ( لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ
____________________
= لا يجرح الحبل الذي يشدّ به وسط الدابة جنبه، وفي نسخة أخرى ورواية أخرى للخطبة: «لا يكلّم خشاشه» بكسر الخاء المعجمة وهو الخشبة التي تجعل في أنف البعير ويشدّ بها الزمام؛ ليكون أسرع لانقياده. وهذه الخشبة قد تجرح أنف البعير، أو تخرمه عند صعوبة السير، ولا يكون ذلك مع سهولة السير.
١ - أورد الإبل الماء: جاء بها ليسقيه. والمنهل: الماء الذي يقع في طريق السائر.
٢ - النمير: الزاكي النامي.
٣ - طفح الإناء: امتلأ وفاض.
٤ - ترنق الماء: تكدر.
٥ - يعني: يرجعهم شباعاً مكتفين. وذلك كلّه لبيان كفاءته (عليه السّلام) وحسن رعايته للرعية.
٦ - النهل: الشرب الأوّل. وفيه إشارة إلى اكتفائه (عليه السّلام) بالقليل.
٧ - الكافل: ذو العيال. ومن شأنه أن يكتفي لنفسه بمقدار الحاجة، وسدّ الرمق من أجل أن يكفي عياله.
٨ - سورة الأعراف/٩٦.
٩ - سورة الزمر/٥١.
١٠ - احتنكه: استولى عليه. واحتنك الجراد الأرض: كلّ ما عليه. ومنه قوله تعالى عن إبليس:( لأَحتَنِكنَّ ذُريتَهُ إلّا قَليلاً ) . ومرادها (عليها السّلام) بالذرية ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
الْعَشِيرُ ) (١) ، و( بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً ) (٢) ، استبدلوا والله الذنابى بالقوادم(٣) ، والعجز بالكاهل(٤) ، فرغماً لمعاطس قوم يحسبون أنّهم يحسنون صنعاً.( أَلا أنّهم هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ ) (٥) . ويحهم( أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الحقّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) (٦) ؟!.
أما لعمري لقد لقحت، فنظرة ريثما تنتج(٧) ، ثمّ احتلبوا ملء القعب(٨) دماً عبيطاً، وزعافاً مبيداً(٩) ، هنالك( يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ ) (١٠) ، ويعرف البطالون(١١) غبّ(١٢) ما أسّس الأوّلون، ثمّ طيبوا عن دنياكم أنفساً، واطمئنوا للفتنة جاشاً(١٣) ، وأبشروا بسيف صارم، وسطوة معتدٍ غاشم، وبهرج شامل، واستبداد
____________________
١ - سورة الحج/١٣.
٢ - سورة الكهف/٥٠.
٣ - الذنابى: الذنب. والقوادم: مقاديم ريش الطائر، أو أربع ريشات في مقدم جناحه.
٤ - العجز: مؤخّر الجسم أو مؤخّر كلّ شيء. والكاهل: أعلى الظهر ممّا يلي العنق. وكاهل القوم: معتمدهم في الملمات وسندهم في المهمات.
٥ - سورة البقرة/١٢.
٦ - سورة يونس/٣٥.
٧ - شبّهت (عليها السّلام) الفتنة في نقل الخلافة عن موضعها بالجنين الذي يبدأ بلقاح الأنثى من دون أن يكون له مظهر، ولا يظهر إلّا بإنتاج الدابة وولادتها. ثمّ استعرضت (عليها السّلام) ما يترتّب على الفتنة المذكورة بعد الإنتاج من المآسي والسلبيات المريعة.
٨ - القعب: القدح الضخم الغليظ.
٩ - سمّ زعاف: يقتل سريعاً. يعني: إنّ الخير الذي ينتظرونه من الدين الحنيف ينقلب وبالاً. فهم بدل أن يحتلبوا اللبن السائغ يحتلبوا الدم العبيط والسمّ القاتل.
١٠ - سورة الجاثية/٢٧.
١١ - البطال: الفارغ المتعطل عن العمل. ولا يتضح وجه مناسبته للمقام. ومن الظاهر أنّ الصحيح ما في النسخ الأخر وطرق الخطبة الأخر، وهو: «ويعرف التالون...» وهو جمع التالي، بمعنى المتأخّر.
١٢ - الغب بالكسر: العاقبة.
١٣ - جاش: غلا وهاج واضطر. وكأن مرادها (عليها السّلام): وطنوا أنفسكم على هيجان الفتن وتتابعها.
من الظالمين يدع فيئكم زهيداً، وجمعكم حصيداً(١) ، فيا حسرة لكم! وأنّى بكم وقد عميت عليكم!(٢) ( أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ) (٣» ).
قال سويد بن غفلة فأعادت النساء قولها (عليها السّلام) على رجالهنّ؛ فجاء إليها قوم من المهاجرين والأنصار متعذرين، وقالوا: يا سيّدة النساء، لو كان أبو الحسن ذكر لنا هذا الأمر قبل أن يبرم العهد، ويحكم العقد لما عدلنا عنه إلى غيره.
فقالت (عليها السّلام): إليكم عنّي فلا عذر بعد تعذيركم(٤) ، ولا أمر بعد تقصيركم.
____________________
١ - حصد القوم بالسيف: قتلهم.
٢ - كناية عن جهلهم بسوء عاقبة عملهم.
٣ - سورة هود/٢٨.
٤ - التعذير في الأمر التقصير فيه. وعذّر الرجل: لم يثبت له عذر. وذلك إذا لم يأت بعذر صدق.
مصادر الخطبة
وردت هذه الخطبة في مصادر كثيرة:
١- قال ابن طيفور أحمد بن أبي طاهر: وحدّثني هارون بن مسلم بن سعدان، عن الحسن بن علوان، عن عطية العوفي، قال: لما مرضت فاطمة (عليها السّلام) المرضة التي توفّيت بها دخل النساء عليها...(١) .
٢- قال ابن أبي الحديد: قال أبو بكر: وحدّثنا محمد بن زكريا، قال: حدّثنا محمد بن عبد الرحمن المهلبي، عن عبد الله بن حماد بن سليمان، عن أبيه، عن عبد الله بن حسن بن حسن، عن أُمّه فاطمة بنت الحسين (عليها السّلام)، قالت: لما اشتدّ بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوجع، وثقلت في علّتها اجتمع عندها نساء...(٢) .
٣- ورواها جماعة كاملة من دون ذكر السند، كابن الدمشقي(٣) ، والآبي(٤) ، والسيّدة زينب العاملية(٥) .
٤- قال الصدوق: حدّثنا أحمد بن الحسن القطان، قال: حدّثنا عبد الرحمن بن محمد الحسيني، قال: حدّثنا أبو الطيب محمد بن الحسين بن حميد اللخمي، قال: حدّثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا، قال: حدّثنا محمد بن عبد الرحمن المهلبي، قال: حدّثنا عبد الله بن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن عبد الله بن الحسن، عن أُمّه فاطمة بنت الحسين (عليهما السّلام)، قالت: لما اشتدّت علّة فاطمة بنت رسول الله (صلوات الله عليها)...
____________________
١ - بلاغات النساء/١٩ - ٢٠ كلام فاطمة وخطبها.
٢ - شرح نهج البلاغة ١٦/٢٣٣.
٣ - جواهر المطالب في مناقب الإمام علي (عليه السّلام) ١/١٦٤ - ١٦٨.
٤ - نثر الدر ٤/٨ الباب الأوّل كلام للنساء الشرائف، فاطمة ابنة رسول الله (عليها السّلام)، قولها عند احتضارها.
٥ - الدرّ المنثور في طبقات ربات الخدور/٢٣٣ في ذكر زينب بنت الإمام علي (كرّم الله وجهه).
وحدّثنا بهذا الحديث أبو الحسن علي بن محمد بن الحسن، المعروف بابن مقبرة القزويني، قال: أخبرنا أبو عبد الله جعفر بن محمد بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام)، قال: حدّثني محمد بن علي الهاشمي، قال: حدّثنا عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب (عليه السّلام)، قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام)، قال: «لمّا حضرت فاطمة (عليها السّلام) الوفاة دعتني، فقالت: أمنفّذ أنت وصيّتي وعهدي؟...».
قال: فلما اشتدت علتها اجتمع إليها نساء المهاجرين والأنصار...»(١) .
٥ - قال الشيخ الطوسي: أخبرنا الحفّار، قال: حدّثنا الدعبلي، قال: حدّثنا أحمد بن علي الخزاز ببغداد بالكرخ بدار كعب، قال: حدّثنا أبو سهل الرفاء، قال: حدّثنا عبد الرزاق، قال الدعبلي: وحدّثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الدبري، بصنعاء اليمن في سنة ثلاث وثمانين ومئتين، قال: حدّثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس قال: دخلت نسوة من المهاجرين والأنصار على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعدنها في علتها...(٢) .
٦ - وقال الطبري(٣) : حدّثني أبو المفضل محمد بن عبد الله، قال: حدّثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، قال: حدّثني محمد بن المفضل بن إبراهيم بن المفضل بن قيس الأشعري، قال: حدّثنا علي بن حسان، عن عمّه عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليه السّلام)، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين (عليهم السّلام)، قال: «لمّا رجعت فاطمة إلى منزلها فتشكّت، وكانت وفاتها
____________________
١ - معاني الأخبار/٣٥٤ - ٣٥٦.
٢ - الأمالي - للطوسي/٣٧٤.
٣ - دلائل الإمامة/١٢٥ - ١٢٩.
في هذه المرضة، دخل إليها النساء المهاجرات والأنصاريات...».
وحدّثني أبو إسحاق إبراهيم بن مخلد بن جعفر الباقرحي، قال: حدّثتني أُمّ الفضل خديجة بنت أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي الثلج، قالت: حدّثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد الصفواني، قال: حدّثنا أبو أحمد عبد العزيز بن يحيى الجلودي، قال: حدّثني محمد بن زكريا، قال: حدّثنا محمد بن عبد الرحمان المهلبي، قال: حدّثنا عبد الله بن محمد بن سليمان المدائني، قال: حدّثني أبي، عن عبد الله بن الحسن بن الحسن، عن أُمّه فاطمة بنت الحسين، قالت: لما اشتدّت علّة فاطمة (عليها السّلام)....
٧- وقال ابن جبر(١) : وقد قالت في خطبتها التي رواها كثير من العلماء في مواضع كثيرة لا تُحصى كثرة. والنقل من كتاب جدّي أبي عبد الله الحسين بن جبير (رحمه الله)، المعروف بكتاب الاعتبار في إبطال الاختيار، فمن جملة خطبتها (عليها السّلام) أنّها قالت: «أصبحت والله عائفة...».
____________________
١ - نهج الإيمان - لابن جبر/٦٢١.
ملحق رقم (٣)
خطبة السيّدة زينب (عليها السّلام) في الكوفة
قال الخوارزمي(١) : قال بشير بن حذيم الأسدي: نظرت إلى زينب بنت علي يومئذٍ - ولم أرَ خفرة قطّ أنطق منها، كأنّما تنطق عن لسان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السّلام) وتفرغ عنه - أومأت إلى الناس أن اسكتوا. فارتدّت الأنفاس، وسكنت الأجراس.
فقالت: الحمد لله، والصلاة على أبي محمد رسول الله وعلى آله الطيبين الأخيار آل الله.
وبعد يا أهل الكوفة، ويا أهل الختل(٢) والخذل، والغدر! أتبكون؟ فلا رقأت الدمعة(٣) ، ولا هدأت الرنّة. إنّما مثلكم كمثل( الَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قوّة أَنكَاثاً ) (٤) أتتخذون أيمانكم دخلاً بينكم؟(٥) ألا وهل فيكم إلّا الصلف(٦) ،
____________________
١ - مقتل الحسين ٢/٤٠ - ٤٢.
٢ - الختل بالفتح والسكون: الغدر.
٣ - رقأ الدمع والدم: جفّ. وهي (عليها السّلام) تشير بذلك إلى عِظَم الفاجعة بحيث تستحق الاستمرار بالبكاء تفجع، أو إلى عِظَم الجريمة بحيث تستحق الاستمرار بالبكاء ندم.
٤ - سورة النحل/٩٢.
٥ - وفي بعض طرق الخطبة:( تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ ) . فتكون تتمّة الآية الشريفة.
٦ - صلِف صلفاً: تمدح بما ليس فيه، أو بما ليس عنده، وادّعى فوق ذلك إعجاباً وتكبّراً.
والطنف(١) ، والشنف(٢) ، والنطف(٣) ، وملق الإماء(٤) ، وغمز الأعداء(٥) ، أو كمرعى على دمنة(٦) ، أو كقصّة على ملحودة!(٧) ألا ساء ما قدّمت لكم أنفسكم، أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون.
أتبكون وتنتحبون؟ إي والله، فابكوا كثيراً واضحكوا قليلاً، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها(٨) ، ولن ترحضوها(٩) بغسل بعدها أبداً.
وأنّى ترحضون قتل سليل خاتم الأنبياء، وسيّد شباب أهل الجنّة، وملاذ خيرتكم(١٠) ، ومفزع نازلتكم، ومنار حجّتكم، ومدره ألسنتكم(١١) . ألا ساء ما تزرون، وبعداً لكم وسحقاً، فلقد خاب السعي، وتبّت الأيدي، وخسرت الصفقة، وبؤتم بغضب من الله، وضُربت عليكم الذلّة والمسكنة.
ويلكم يا أهل الكوفة، أتدرون أيّ كبد لرسول الله فريتم؟ وأيّ دم له سفكتم؟ وأيّ كريمة له أبرزتم؟ وأيّ حريم له أصبتم؟ وأيّ حرمة له انتهكتم؟( لَقَدْ جِئْتُمْ
____________________
١ - طنِفَ طنفاً: اتهم.
٢ - الشنِف بكسر النون: المبغض. والشنَف بفتح النون: البغض والتنكر، أو شدّة البغض.
٣ - النطِف بكسر الطاء: النجس. والرجل النطف: المريب.
٤ - ملقه وملق له ومالقه: تودّد إليه وتذلّل، وأبدى له بلسانه من الإكرام والود ما ليس له. ونسبته للإماء للكناية عن الهوان وضعف النفس.
٥ - الغمز: الطعن والسعي بالشرّ.
٦ - المرعى: الكلأ ونبات الأرض. والدِمنة بكسر الدال: المزبلة.
٧ - القصة: الجصة. والملحودة: القبر. فشبّهتهم (عليها السّلام) بالجص الذي يجصص به القبر في حسن الظاهر وفساد الباطن. وبذلك تؤكّد مضامين الفقرات السابقة.
٨ - الشنار: أقبح العيب.
٩ - فسر الرحض بالغسل. ومرادها (عليها السّلام) هنا أثره، وهو إزالة القذر؛ لبيان أنّ عار الجريمة لازم لهم، لا ينفع شيء في رفعه ونسيانه.
١٠ - يعني: الذي يلوذ به ويلجأ إليه خياركم. وفي بعض طرق الخطبة: وملاذ حيرتكم، بالحاء المهملة. يعني: الذي تلوذون به، وتلجأون إليه عند تحيّركم واشتباه الأمور عليكم.
١١ - المِدره بكسر الميم وسكون الدال وفتح الراء: زعيم القوم المتكلّم عنهم.
شَيْئاً إِدّاً * تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدّاً ) (١) .
إنّما جئتم بها لصلعاء عنقاء(٢) ، سوءاء(٣) ، فقماء(٤) ، خرقاء(٥) ، شوهاء(٦) كطلاع الأرض(٧) ، وملأ السماء(٨) . أفعجبتم أن قطرت السماء دماً؟ ولعذاب الآخرة أشدّ وأخزى وأنتم لا تنصرون.
فلا يستخفّنكم المهل؛ فإنّه (عزّ وجلّ) لا يحفزه البدار(٩) ، ولا يخاف فوت الثار. كلا إنّ ربكم لبالمرصاد، فترقّبوا أوّل النحل(١٠) وآخر صاد(١١) .
قال بشير: فوالله، لقد رأيت الناس يومئذٍ حيارى، كأنّهم كانوا سكارى، يبكون ويحزنون، ويتفجعون ويتأسّفون، وقد وضعوا أيديهم في أفواههم.
قال: ونظرت إلى شيخ من أهل الكوفة كان واقفاً إلى جنبي، قد بكى حتى اخضلّت لحيته بدموعه وهو يقول: صدقتِ بأبي وأُمّي. كهولكم خير الكهول، وشبانكم خير الشبان، ونساؤكم خير النسوان، ونسلكم خير نسل، لا يُخزى ولا يُبزى(١٢) .
____________________
١ - سورة مريم/٨٩ - ٩٠.
٢ - الصلعاء: الداهية الشديدة. والعنقاء: الداهية. وكلاهما يبتني على نحو من المجاز.
٣ - السوءاء بمعنى السيئة، والخلّة القبيحة.
٤ - الأمر الأفقم: الأعوج المخالف. ويرد مورد الذم.
٥ - الخرقاء من الخَرَق - بفتح الخاء - والشق، أو مؤنث الأخرق وهو الأحمق. وعلى كلا التقديرين فهي ترد مورد الذم.
٦ - امرأة شوهاء: قبيحة.
٧ - طلاع الأرض: ملؤه. وهو مبالغة في شدّة الذم وكثرته.
٨ - الظاهر أنّ المراد بالسماء هنا الفضاء الواسع بين السماء والأرض. وملؤه مبالغة في شدّة الذم وكثرته، كسابقه.
٩ - يعني: لا يستخفه ويعجله.
١٠ - وهو قوله تعالى:( أَتَى أَمْرُ اللهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ ) .
١١ - وهو قوله تعالى:( وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ) .
١٢ - يعني: لا يُقهر ولا يُغلب.
مصادر الخطبة
وردت هذه الخطبة في مصادر كثيرة:
١- قال ابن طيفور أحمد بن أبي طاهر(١) : عن سعيد بن الحميري أبي معاذ، عن عبد الله بن عبد الرحمن - رجل من أهل الشام -، عن شعبة، عن حذام الأسدي - وقال مرّة أُخرى حذيم - قال: قدمت الكوفة سنة إحدى وستين وهي السُنّة التي قُتل فيها الحسين (عليه السّلام) فرأيت نساء أهل الكوفة يومئذٍ يلتدمنَ مهتّكات الجيوب....
وحدّثنيه عبد الله بن عمرو، قال: حدّثني إبراهيم بن عبد ربّه بن القاسم بن يحيى بن مقدم المقدمي، قال: أخبرني سعيد بن محمد أبو معاذ الحميري، عن عبد الله بن الرحمن رجل من أهل الشام، عن حذام الأسدي، قال: قدمت الكوفة سنة إحدى وستين، وهي السُنّة التي قُتل فيها الحسين بن علي (عليه السّلام)....
٢- ورواها جماعة من دون ذكر السند، كابن أعثم(٢) ، والآبي(٣) ، وابن حمدون(٤) ، وأحمد زكي صفوت(٥) .
٣- قال الشيخ المفيد(٦) : أخبرني أبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني، قال: حدّثني أحمد بن محمد الجوهري، قال: حدّثنا محمد بن مهران، قال: حدّثنا
____________________
١ - بلاغات النساء/٢٣ - ٢٥ كلام أُمّ كلثوم بنت علي (عليها السّلام).
٢ - الفتوح - لابن أعثم ٥/١٣٩ - ١٤١ ذكر كلام زينب بنت علي (رضي الله عنهما).
٣ - نثر الدرّ ٤/١٩ - ٢٠ الباب الأوّل كلام للنساء الشرائف، أُمّ كلثوم بنت علي.
٤ - التذكرة الحمدونية ٢/٢٣٥ الباب الثلاثون في الخطب.
٥ - جمهرة خطب العرب ٢/١٣٤ - ١٣٦ الباب الثالث الخطب والوصايا في العصر الأموي، خطب بني هاشم وشيعتهم وما يتصل بها، خطبة السيدة أُمّ كلثوم بنت علي في أهل الكوفة بعد مقتل الحسين (عليه السّلام).
٦ - الأمالي - للمفيد/٣٢٠ - ٣٢١.
موسى بن عبد الرحمن المسروقي، عن عمر بن عبد الواحد، عن إسماعيل بن راشد، عن حذلم بن ستير، قال: قدمت الكوفة في المحرّم سنة إحدى وستين عند منصرف علي بن الحسين (عليهما السّلام) بالنسوة من كربلاء، ومعهم الأجناد محيطون بهم وقد خرج الناس للنظر إليهم، فلمّا أقبل بهم على الجمال بغير وطاء جعل نساء أهل الكوفة....
كما رواها الشيخ الطوسي(١) عن الشيخ المفيد (رضوان الله عليهما) بالسند المتقدّم.
٤- وقد رويت في مصادر كثيرة عند الشيعة(٢) .
____________________
١ - الأمالي - للطوسي/٩١ - ٩٢.
٢ - راجع الاحتجاج ٢/٢٩، ومناقب آل أبي طالب - لابن شهرآشوب ٣/٢٦١، ومثير الأحزان/٦٦ - ٦٧، واللهوف في قتلى الطفوف/٨٦ - ٨٨، وغيرها من المصادر.
ملحق رقم (٤)
خطبة السيّدة زينب (عليها السّلام)
في مجلس يزيد في الشام
قال الخوارزمي(١) : لما أُدخل رأس الحسين وحرمه على يزيد بن معاوية، وكان رأس الحسين بين يديه في طست جعل ينكت ثناياه بمخصرة في يده ويقول:
ليتَ أشياخي ببدرٍ شهدوا |
جزعَ الخزرجِ من وقعِ الأسل |
|
لأهلّوا واستهلّوا فرحا |
ثمّ قالوا يا يزيدَ لا تُشل |
|
لستُ من خندف إن لم أنتقم |
من بني أحمد ما كانَ فعل |
فقامت زينب بنت علي، وأُمّها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسّلام على سيّد المرسلين. صدق الله تعالى إذ يقول:( ثمّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا السُّوأَى أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِؤُون ) (٢) .
أظننت يا يزيد - حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، وأصبحنا نساق كما تساق الأسارى - أنّ بنا هواناً على الله وبك عليه كرامة، وأنّ ذلك لعِظَم
____________________
١ - مقتل الحسين ٢/٦٤ - ٦٦.
٢ - سورة الروم/١٠.
خَطَرِك(١) عنده، فشمخت بأنفك، ونظرت في عِطفك(٢) ، [تضرب أصدريك(٣) فرحاً، وتنفض مذوريك(٤) مرحاً](٥) ، جذلان(٦) مسروراً، حين رأيت الدنيا لك مستوسقة(٧) ، والأمور متّسقة(٨) ، وحين صفا لك ملكنا وسلطاننا.
فمهلاً مهلاً، أنسيت قول الله تعالى:( وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ إنّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إنّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْماً وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ) (٩) .
أمن العدل يابن الطلقاء(١٠) تخديرك(١١) حرائرك وإمائك، وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهنَّ، وأبديت وجوههنَّ، يُحدى بهنَّ من بلد إلى بلد، ويستشرفهنَّ(١٢) أهل المناهل والمناقل(١٣) ، ويتصفّح(١٤) وجوههنَّ القريب والبعيد، والدني والشريف. ليس معهنَّ من رجالهنَّ ولي، ولا من حماتهنَّ حمي.
____________________
١ - الخطر: رفعة الشأن والمقام.
٢ - عِطف الشيء: جانبه. والنظر في العطف كناية عن الإعجاب بالنفس.
٣ - الأصدران: عرقان يضربان تحت الصدغين. يُقال: جاء يضرب أصدريه. يعني جاء فارغاً. ولعلّها (عليها السّلام) أرادت فراغ باله، وانكشاف همّه؛ نتيجة ظفره وانتصاره.
٤ - المذوران: طرفا الإليتين. ومنه جاء ينفض مذوريه. أي باغياً مهدّداً.
٥ - لم ترد هذه الفقرة في مقتل الخوارزمي، وذكرت في مصادر أخرى.
٦ - الجذلان: الفرح.
٧ - استوسق: اجتمع وانقاد. واستوسق الأمر: انتظم.
٨ - اتسق الأمر: انتظم واستوى.
٩ - سورة آل عمران/١٧٨.
١٠ - الطلقاء: هم الذين عفا عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مشركي قريش بعد فتح مكة، وقال لهم في حديث له معهم: «فاذهبوا فأنتم الطلقاء». ومنهم معاوية أبو يزيد.
١١ - الخِدر بكسر الخاء: ما يفرد للنساء من السكن ويستترنَ به. وخدّر البنت: ألزمها الخِدر.
١٢ - استشرف الشيء: رفع بصره لينظر إليه باسطاً كفه فوق حاجبه.
١٣ - المناهل: المياه التي على طريق الرحل والمسافرين. والمناقل: الطرق المختصرة، أو الطرق في الجبال.
١٤ - تصفّح القوم: تأمّل وجوههم؛ ليتعرّف أمرهم.
وكيف ترجى المراقبة ممّنْ لفظ فوه(١) أكباد السعداء، ونبت لحمه بدماء الشهداء؟! وكيف لا يُستبطأ في بغضنا أهل البيت مَنْ نظر إلينا بالشنَف والشنَآن(٢) ، والإحَن(٣) والأضغان؟! ثمّ تقول غير متأثّم ولا مستعظم:
لأهلّوا واستهلّوا فرحاً |
ثمّ قالوا يا يزيدَ لا تُشل |
منحنياً على ثنايا أبي عبد الله تنكتها بمخصرتك(٤) .
وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرحة(٥) ، واستأصلت الشأفة(٦) ، بإراقتك دماء آل ذرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونجوم الأرض من آل عبد المطلب.
أتهتف بأشياخك زعمت تناديهم، فلتردنَّ وشيكاً موردهم، ولتودّنَّ أنّك شُللت وبُكمت، ولم تكن قلت ما قلت.
اللّهمّ خذ بحقنا، وانتقم ممّنْ ظلمنا، وأحلل غضبك بمَنْ سفك دماءنا، وقتل حماتنا.
فوالله ما فريت إلّا جلدك، ولا جززت إلّا لحمك(٧) ، ولتردنَّ على رسول
____________________
١ - يعني: فمه وفيه. إشارة إلى أنّ هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، وأُمّ معاوية وجدّة يزيد بقرت بطن حمزة عمّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستخرجت كبده وأرادت أكلها فمضغتها فلم تستسغها؛ لأنّها صارت حجراً في فمها؛ فلفظتها ورمت بها.
٢ - الشنَف: البغض. والشنَآن: البغض مع عداوة وسوء خلق.
٣ - الإحن جمع إحنة: الحقد الكامن المضمر.
٤ - نكت الشيء بالقضيب: ضربه به في حال التفكّر بنحو يؤثّر فيه. والمخصرة بكسر الميم: العصا ونحوها ممّا يتوكأ عليه.
٥ - نكأ القرحة: قشرها قبل أن تبرأ. وهو كناية عن العدوان بتهييج المصائب والآلام.
٦ - شأفة الرجل: أهله وماله. ورجل شأفة: عزيز منيع.
٧ - كأنّها (عليها السّلام) تشير إلى سوء عاقبة عمله عليه. نظير قوله تعالى:( مَن عَمِل صالِحاً فلِنَفسِهِ وَمَن أَساءَ فَعَلَيه ) سورة فصلت/٤٦.
الله بما تحمّلت من سفك دماء ذريته، وانتهاك حرمته في لحمته(١) وعترته، وليخاصمنّك حيث يجمع الله تعالى شملهم، ويلمّ شعثهم(٢) ، ويأخذ لهم بحقّهم.( وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ) (٣) . فحسبك بالله حاكماً، وبمحمد خصماً، وبجبرائيل ظهيراً.
وسيعلم من سوّل لك، ومكّنك من رقاب المسلمين أن( بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً ) (٤) ، وأيّكم( شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضْعَفُ جُند ) (٥) .
ولئن جرت عليّ الدواهي مخاطبتك؛ فإنّي لأستصغر قدرك، وأستعظم تقريعك، وأستكبر توبيخك، لكنّ العيون عبرى، والصدور حرّى.
ألا فالعجب كلّ العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. فتلك الأيدي تنطف(٦) من دمائنا، وتلك الأفواه تتحلّب(٧) من لحومنا، وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل(٨) ، وتعفوها الذئاب، وتؤمّها الفراعل(٩) .
فلئن اتخذتنا مغنماً لتجدنا وشيكاً(١٠) مغرماً، حين لا تجد إلّا ما قدّمت
____________________
١ - اللُحمة بضم اللام: القرابة.
٢ - الشعث: انتشار الأمر. يُقال: لمّ الله شعثهم. أي جمع أمرهم.
٣ - سورة آل عمران/١٦٩.
٤ - سورة الكهف/٥٠.
٥ - سورة مريم/٧٥.
٦ - نطف: تلطخ بعيب.
٧ - تحلب فمه: سال بالريق.
٨ - تنتابها: تتردّد عليه. والعواسل: الذئاب.
٩ - عفره: مرغه وقلبه في التراب. والفراعل جمع فرعل: ولد الضبع. والمعنى أنّ الضباع تقلّبها في التراب. وكأنّها (عليها السّلام) تشير إلى أنّهم بتركهم تلك الجثث الزواكي من دون دفن جعلوها عرضة للذئاب والضباع. ولا ينافي ذلك أنّ الله سبحانه يسّر لها مَنْ يدفنها ويمنعها من أن تنتهك حرمتها.
١٠ - يعني: قريباً وسريعاً.
يداك. وأنّ الله ليس بظلام للعبيد، فإلى الله المشتكى، وعليه المعول.
فكد كيدك، واسعَ سعيك، وناصب(١) جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا، ولا تُميت وحينا، ولا تدرك أمدنا(٢) ، ولا ترحض(٣) عنك عارها، ولا تغيب منك شنارها.
فهل رأيك إلّا فند(٤) ، وأيّامك إلّا عدد(٥) ، وشملك إلّا بدد، يوم ينادي المنادي:( أَلاَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمينَ ) (٦) .
فالحمد لله الذي ختم لأوّلنا بالسعادة والرحمة، ولآخرنا بالشهادة والمغفرة. وأسأل الله أن يكمل لهم الثواب، ويوجب لهم المزيد، وحسن المآب، ويختم بنا الشرافة، إنّه رحيم ودود، و( حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ) (٧) ( نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ) (٨) .
____________________
١ - ناصبه: عاداه وقاومه.
٢ - أمد الخيل في الرهان: منتهى غاياتها التي تسبق إليها. ومرادها (عليها السّلام) الكناية عن مدى شرفهم (عليهم السّلام) ورفعة شأنهم.
٣ - الرحض: الغسل، وروي (تدحض) بالدال من الدحض وهو الدفع.
٤ - الفَنَدْ: الخطّ.
٥ - يعني: معدودة. وذلك كناية عن قلته.
٦ - سورة هود/١٨.
٧ - سورة آل عمران/١٧٣.
٨ - سورة الأنفال/٤٠.
مصادر الخطبة
وردت هذه الخطبة في مصادر كثيرة:
وقد رواها الخوارزمي(١) بسنده، قال: أخبرنا الشيخ الإمام مسعود بن أحمد، فيما كتب إليّ من دهستان، أخبرنا شيخ الإسلام أبو سعد المحسن بن محمد بن كرامة الجشمي، أخبرنا الشيخ أبو حامد، أخبرنا أبو حفص عمر بن الجازي بنيسابور، أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد المؤدّب الساري، حدّثنا أبو الحسين محمد بن أحمد الحجري، أخبرنا أبو بكر محمد بن دريد الأزدي، حدّثنا العكي، عن الحرمازي، عن شيخ من بني تميم من أهل الكوفة، قال: لما أُدخل....
ورواها جماعة كاملة من دون ذكر السند، كابن طيفور(٢) ، وابن حمدون(٣) ، وأحمد زكي صفوت(٤) وكحالة(٥) .
كما رويت في مصادر الشيعة(٦) .
____________________
١ - مقتل الحسين/٦٣ - ٦٤.
٢ - بلاغات النساء/٢١ - ٢٣ كلام زينب بنت علي (عليها السّلام).
٣ - التذكرة الحمدونية ٢/٢٣٤ الباب الثلاثون في الخطب.
٤ - جمهرة خطب العرب ٢/١٣٦ - ١٣٩ الباب الثالث الخطب والوصايا في العصر الأموي، خطب بني هاشم وشيعتهم وما يتصل بها، خطبة السيدة زينب بنت علي (عليها السّلام) بين يدي يزيد.
٥ - أعلام النساء ٢/٩٥ - ٩٧.
٦ - راجع الاحتجاج ٢/٣٤، واللهوف في قتلى الطفوف/١٠٥ - ١٠٨، ومثير الأحزان/٨٠ - ٨١، وغيرها من المصادر.
ملحق رقم (٥)
خطبة الإمام زين العابدين (عليه السّلام)
قال الخوارزمي(١) : إنّ يزيد أمر بمنبر وخطيب؛ ليذكر للناس مساوئ للحسين وأبيه علي (عليهما السّلام)، فصعد الخطيب المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، وأكثر الوقيعة في علي والحسين، وأطنب في تقريظ معاوية ويزيد.
فصاح به علي بن الحسين: «ويلك أيّها الخاطب! اشتريت رضى المخلوق بسخط الخالق، فتبوّأ مقعدك من النار».
ثمّ قال: «يا يزيد، ائذن لي حتى أصعد هذه الأعواد؛ فأتكلّم بكلمات فيهنّ لله رضى، ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب». فأبى يزيد.
فقال الناس: يا أمير المؤمنين ائذن له ليصعد؛ فلعلّنا نسمع منه شيئاً.
فقال لهم: إن صعد المنبر هذا لم ينزل إلّا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان.
فقالوا: وما قدر ما يحسن هذا؟!
فقال: إنّه من أهل بيت قد زقّوا العلم زقّا. ولم يزالوا به حتى أذن له بالصعود.
فصعد المنبر. فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ خطب خطبة أبكى منها العيون، وأوجل منها القلوب. فقال فيها: «أيّها الناس، أُعطينا ستاً، وفضّلنا بسبع. أُعطينا العلم، والحلم، والسماحة، والفصاحة، والشجاعة، والمحبّة في قلوب المؤمنين. وفضّلنا بأنّ منّا النبي المختار محمداً صلى الله عليه وآله وسلم، ومنّا الصدّيق، ومنّا الطيار، ومنّا أسد
____________________
١ - مقتل الحسين ٢/٦٩ - ٧١.
الله وأسد الرسول، ومنّا سيّدة نساء العالمين فاطمة البتول، ومنّا سبطا هذه الأُمّة وسيّدا شباب أهل الجنّة.
فمَنْ عرفني فقد عرفني ومَنْ لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي.
أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن مَنْ حمل الزكاة(١) بأطراف الردا، أنا ابن خير مَنْ ائتزر وارتدى، أنا ابن خير مَنْ انتعل واحتفى، أنا ابن خير مَنْ طاف وسعى، أنا ابن خير مَنْ حجّ ولبّى.
أنا ابن مَنْ حُمل على البراق في الهوا، أنا ابن مَنْ أُسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فسبحان مَنْ أسرى.
أنا ابن مَنْ بلغ به جبرئيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن مَنْ دنا فتدلى فكان من ربّه قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن مَنْ صلّى بملائكة السماء، أنا ابن مَنْ أوحى إليه الجليل ما أوحى.
أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن مَنْ ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا: لا إله إلّا الله. أنا ابن مَنْ ضرب بين يدي رسول الله بسيفين، وطعن برمحين، وهاجر الهجرتين، وبايع البيعتين، وصلّى القبلتين، وقاتل ببدر وحنين، ولم يكفر بالله طرفة عين.
أنا ابن صالح المؤمنين، ووارث النبيين، وقامع الملحدين، ويعسوب المسلمين، ونور المجاهدين، وزين العابدين، وتاج البكائين، وأصبر الصابرين، وأفضل القائمين من آل ياسين رسول ربّ العالمين.
____________________
١ - في بعض طرق الخطبة: «أنا ابن مَنْ حمل الركن بأطراف الردا». إشارة إلى تنازع قبائل قريش عند بنائهم للكعبة الشريفة، فيمَنْ تولّى منهم حمل الحجر الأسود، ويضعه في موضعه، ثمّ تحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، فأمر بجعل الحجر في رداء، ثمّ أخذ رجل من كلّ قبيلة بطرف من الرداء حتى رفعوه إلى مكانه. ثمّ أخذه صلى الله عليه وآله وسلم بيده الشريفة فوضعه في موضعه.
أنا ابن المؤيّد بجبرئيل، المنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين، وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، والمجاهد أعداءه الناصبين، وأفخر مَنْ مشى من قريش أجمعين، وأوّل مَنْ أجاب واستجاب لله من المؤمنين، وأقدم السابقين، وقاصم المعتدين، ومبير المشركين، وسهم من مرامي الله على المنافقين، ولسان حكمة العابدين، وناصر دين الله، وولي أمر الله، وبستان حكمة الله، وعيبة علم الله.
سمح، سخي، بهلول(١) ، زكي، أبطحي، رضي، مرضي، مقدام، همام، صابر، صوام، مهذب، قوام، شجاع، قمقام(٢) ، قاطع الأصلاب، ومفرّق الأحزاب.
أربطهم جناناً، وأطلقهم عناناً، وأجرأهم لساناً، وأمضاهم عزيمة، وأشدّهم شكيمة، أسد باسل، وغيث هاطل، يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنّة، وقربت الأعنّة طحن الرحا، ويذروهم فيها ذرو الريح الهشيم، ليث الحجاز، وصاحب الإعجاز، وكبش العراق، الإمام بالنصّ والاستحقاق.
مكي مدني، أبطحي تهامي، خيفي عقبي، بدري أحدي، شجري مهاجري، من العرب سيّدها، ومن الوغى ليثها، وارث المشعرين، وأبو السبطين، الحسن والحسين، مظهر العجائب، ومفرّق الكتائب، والشهاب الثاقب، والنور العاقب، أسد الله الغالب، مطلوب كلّ طالب، غالب كلّ غالب، ذاك جدّي علي بن أبي طالب.
أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيّدة النساء، أنا ابن الطهر البتول، أنا ابن بضعة الرسول...».
____________________
١ - البهلول: السيد الجامع لكلّ خير.
٢ - القمقام: السيد الكثير العطاء.
ولم يزل يقول: أنا أنا، حتى ضجّ الناس بالبكاء والنحيب، وخشي يزيد أن تكون فتنة؛ فأمر المؤذّن أن يؤذّن، فقطع عليه الكلام وسكت. فلمّا قال المؤذّن: الله أكبر. قال علي بن الحسين: «كبّرت كبيراً لا يُقاس ولا يُدرك بالحواس. لا شيء أكبر من الله».
فلمّا قال: أشهد أن لا إله إلّا الله. قال علي: «شهد بها شعري وبشري، ولحمي ودمي، ومخّي وعظمي».
فلمّا قال: أشهد أنّ محمداً رسول الله. التفت علي من أعلى المنبر إلى يزيد وقال: «يا يزيد، محمد هذا جدّي أم جدّك؟ فإنّ زعمت أنّه جدّك فقد كذبت، وإن قلت أنّه جدّي فلِمَ قتلت عترته؟!».
قال: وفرغ المؤذّن من الأذان والإقامة فتقدّم يزيد وصلّى صلاة الظهر.
هذا ما ذكر الخوارزمي من الخطبة مع تصريحه بأنّها أطول من ذلك. وقد ذكر ابن شهرآشوب(١) الفقرات الأخيرة مع زيادة كما يأتي:
«أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن خديجة الكبرى، أنا ابن المقتول ظلماً، أنا ابن المحزوز الرأس من القفا، أنا ابن العطشان حتى قضى، أنا ابن طريح كربلاء، أنا ابن مسلوب العمامة والرداء، أنا ابن مَنْ بكت عليه ملائكة السماء، أنا ابن مَنْ ناحت عليه الجنّ في الأرض والطير في الهواء، أنا ابن مَنْ رأسه على السنان يُهدى، أنا ابن مَنْ حرمه من العراق إلى [الشام. ظ] تُسبى...».
وذلك هو الأنسب بضجيج الناس بالبكاء الذي تقدّم من الخوارزمي؛ لِما تضمّنته هذه الفقرات من الإشارة للمصائب والفجائع المهيّجة.
____________________
١ - مناقب آل أبي طالب - لابن شهرآشوب ٣/٣٠٥.
مصادر الخطبة
وردت هذه الخطبة في مصادر كثيرة:
فقد رواها ابن أعثم(١) بتمامه، وروى بعضها الأصفهاني(٢) .
وقال ابن شهرآشوب(٣) : وفي كتاب الأحمر قال الأوزاعي: لما أُتي بعلي بن الحسين ورأس أبيه إلى يزيد بالشام....
واكتفى السيد ابن طاووس(٤) ، وابن نما(٥) بذكر مقدّمتها فقط.
____________________
١ - الفتوح - لابن أعثم ٥/١٥٤ - ١٥٥ ذكر كتاب عبيد الله بن زياد إلى يزيد بن معاوية وبعثته إليه برس الحسين بن علي (رضي الله عنهم).
٢ - مقاتل الطالبيين/٨١ مقتل الحسين بن علي (عليهما السّلام).
٣ - مناقب آل أبي طالب - لابن شهرآشوب ٣/٣٠٥.
٤ - اللهوف في قتلى الطفوف/١٠٩.
٥ - مثير الأحزان/٨١.
ملحق رقم (٦)
حديث زائدة
ذكر المجلسي(١) عن ابن قولويه: عبيد الله بن الفضل بن محمد بن هلال، عن سعيد بن محمد، عن محمد بن سلام الكوفي، عن أحمد بن محمد الواسطي، عن عيسى بن أبي شيبة القاضي، عن نوح بن دراج، عن قدامة بن زائدة، عن أبيه قال: قال علي بن الحسين (عليهما السّلام): «بلغني يا زائدة أنّك تزور قبر أبي عبد الله (عليه السّلام) أحياناً؟».
فقلت: إنّ ذلك لكما بلغك.
فقال لي: «فلماذا تفعل ذلك، ولك مكان عند سلطانك الذي لا يحتمل أحداً على محبّتنا وتفضيلنا وذكر فضائلنا، والواجب على هذه الأُمّة من حقّنا؟».
فقلت: والله ما أريد بذلك إلّا الله ورسوله، ولا أحفل بسخط من سخط، ولا يكبر في صدري مكروه ينالني بسببه.
فقال: «والله، إنّ ذلك لكذلك». يقولها ثلاثاً وأقولها ثلاثاً.
فقال: «أبشر، ثمّ أبشر، ثمّ أبشر. فلأخبرنّك بخبر كان عندي في النخب المخزونة.
____________________
١ - بحار الأنوار ٢٨/٥٥ - ٦١.
إنّه لما أصابنا بالطفّ ما أصابنا، وقُتل أبي (عليه السّلام)، وقُتل مَنْ كان معه من ولده وإخوته وساير أهله، وحُملت حرمه ونساؤه على الأقتاب يراد بنا الكوفة، فجعلت أنظر إليهم صرعى، ولم يواروا فيعظم ذلك في صدري، ويشتدّ لِما أرى منهم قلقي، فكادت نفسي تخرج، وتبيّنت ذلك منّي عمّتي زينب بنت علي الكبرى.
فقالت: ما لي أراك تجود بنفسك يا بقيّة جدّي وأبي وإخوتي؟
فقلت: وكيف لا أجزع ولا أهلع، وقد أرى سيّدي وإخوتي وعمومتي وولد عمّي وأهلي مصرّعين بدمائهم، مرمّلين بالعراء، مسلّبين لا يكفّنون، ولا يوارون، ولا يعرج عليهم أحد، ولا يقربهم بشر، كأنّهم أهل بيت من الديلم والخزر.
فقالت: لا يُجزِعَنّك ما ترى؛ فوالله إنّ ذلك لعهد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جدّك وأبيك وعمّك.
ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأُمّة لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض، وهم معروفون في أهل السماوات، أنّهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرّقة فيوارونها، وهذه الجسوم المضرّجة. وينصبون لهذا الطفّ علماً لقبر أبيك سيّد الشهداء (عليه السّلام) لا يُدرس أثره، ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأيام. وليجتهدنَّ أئمّة الكفر، وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه، فلا يزداد أثره إلّا ظهوراً، وأمره إلّا علوّاً.
فقلت: وما هذا العهد، وما هذا الخبر؟
فقالت: حدّثتني أُمّ أيمن أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زار منزل فاطمة (عليها السّلام) في يوم من الأيام، فعملت له حريرة (صلّى الله عليهم)، وأتاه علي (عليه السّلام) بطبق فيه تمر. ثمّ قالت أُمّ أيمن: فأتيتهم بعس فيه لبن وزبد. فأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السّلام) من تلك الحريرة، وشرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشربوا من
ذلك اللبن، ثمّ أكل وأكلوا من ذلك التمر والزبد، ثمّ غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده وعلي (عليه السّلام) يصبّ عليه الماء.
فلمّا فرغ من غسل يده مسح وجهه، ثمّ نظر إلى علي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السّلام) نظراً عرفنا فيه السرور في وجهه. ثمّ رمق بطرفه نحو السماء مليّاً، ثمّ وجّه وجهه نحو القبلة، وبسط يديه ودعى. ثمّ خرّ ساجداً وهو ينشج. فأطال النشوج وعلا نحيبه، وجرت دموعه، ثمّ رفع رأسه، وأطرق إلى الأرض، ودموعه تقطر كأنّها صوب المطر، فحزنت فاطمة وعلي والحسن والحسين، وحزنت معهم لِما رأينا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهِبناه أن نسأله.
حتى إذا طال ذلك. قال له علي وقالت له فاطمة: ما يبكيك يا رسول الله؟ لا أبكى الله عينيك، فقد أقرح قلوبنا ما نرى من حالك؟!
فقال: يا أخي، سُررت بكم سروراً ما سُررت مثله قطّ. وإنّي لأنظر إليكم وأحمد الله على نعمته عليّ فيكم، إذ هبط عليّ جبرئيل، فقال: يا محمد، إنّ الله تبارك وتعالى اطّلع على ما في نفسك، وعرف سرورك بأخيك وابنتك وسبطيك. فأكمل لك النعمة، وهنأك العطية، بأن جعلهم وذرياتهم ومحبّيهم وشيعتهم معك في الجنّة، لا يفرّق بينك وبينهم، يُحبَون كما تُحبى، ويعطون كما تُعطى حتى ترضى وفوق الرضى على بلوى كثيرة تنالهم في الدنيا، ومكاره تصيبهم، بأيدي أناس ينتحلون ملّتك، ويزعمون أنّهم من أُمّتك براء من الله ومنك. خبطاً خبطاً، وقتلاً قتلاً، شتّى مصارعهم، نائية قبورهم. خيرة من الله لهم، ولك فيهم. فاحمد الله (عزّ وجلّ) على خيرته، وارضَ بقضائه. فحمدت الله، ورضيت بقضائه بما اختاره لكم.
ثمّ قال جبرئيل: يا محمد، إنّ أخاك مضطهد بعدك، مغلوب على أُمّتك، متعوب من أعدائك، ثمّ مقتول بعدك. يقتله أشرّ الخلق والخليقة، وأشقى البرية،
نظير عاقر الناقة. ببلد تكون إليه هجرته، وهو مغرس شيعته وشيعة ولده. وفيه على كلّ حال يكثر بلواهم ويعظم مصابهم.
وإنّ سبطك هذا - وأومأ بيده إلى الحسين (عليه السّلام) مقتول في عصابة من ذريتك وأهل بيتك، وأخيار من أُمّتك، بضفة الفرات.
بأرض تُدعى كربلاء. من أجلها يكثر الكرب والبلاء على أعدائك وأعداء ذريتك، في اليوم الذي لا ينقضي كربه ولا تفنى حسرته. وهي أطهر بقاع الأرض، وأعظمها حرمة. وإنّها لمن بطحاء الجنّة.
فإذا كان ذلك اليوم الذي يُقتل فيه سبطك وأهله، وأحاطت بهم كتائب أهل الكفر واللعنة، تزعزعت الأرض من أقطارها، ومادت الجبال وكثر اضطرابها، واصطفقت البحار بأمواجها، وماجت السماوات بأهلها؛ غضباً لك يا محمد ولذريتك، واستعظاماً لِما ينتهك من حرمتك، ولشرّ ما تكافى به في ذريتك وعترتك.
ولا يبقى شيء من ذلك إلّا استأذن الله (عزّ وجلّ) في نصرة أهلك المستضعفين المظلومين الذين هم حجّة الله على خلقه بعدك.
فيوحي الله إلى السماوات والأرض والجبال والبحار مَنْ فيهنّ: إنّي أنا الله الملك القادر الذي لا يفوته هارب، ولا يعجزه ممتنع، وأنا أقدر فيه على الانتصار والانتقام. وعزتي وجلالي لأعذبنّ مَنْ وَتَرَ رسولي وصفيي، وانتهك حرمته، وقتل عترته، ونبذ عهده، وظلم أهله، عذاباً لا أُعذبه أحداً من العالمين.
فعند ذلك يضجّ كلّ شيء في السماوات والأرضين بلعن مَنْ ظلم عترتك، واستحلّ حرمتك.
فإذا برزت تلك العصابة إلى مضاجعها تولّى الله (عزّ وجلّ) قبض أرواحها بيده، وهبط إلى الأرض ملائكة من السماء السابعة، معهم آنية من الياقوت
والزمرد، مملوءة من ماء الحياة، وحلل من حلل الجنّة، وطيب من طيب الجنّة، فغسلوا جثثهم بذلك الماء، وألبسوها الحلل، وحنّطوها بذلك الطيب وصلّى الملائكة صفاً صفاً عليهم.
ثمّ يبعث الله قوماً من أُمّتك لا يعرفهم الكفّار لم يشركوا في تلك الدماء بقول ولا فعل ولا نيّة؛ فيوارون أجسامهم.
ويقيمون رسماً لقبر سيّد الشهداء بتلك البطحاء؛ يكون علماً لأهل الحقّ، وسبباً للمؤمنين إلى الفوز، وتحفّه ملائكة من كلّ سماء مئة ألف ملك في كلّ يوم وليلة، ويصلّون عليه، ويسبّحون الله عنده، ويستغفرون الله لزوّاره.
ويكتبون أسماء مَنْ يأتيه زائراً من أُمّتك متقرّباً إلى الله وإليك بذلك، وأسماء آبائهم وعشائرهم وبلدانهم، ويسمون في وجوههم بميسم نور عرش الله: (هذا زائر قبر خير الشهداء وابن خير الأنبياء). فإذا كان يوم القيامة سطع في وجوههم من أثر ذلك الميسم نور تغشى منه الأبصار، يدلّ عليهم ويعرفون به.
وكأنّي بك يا محمد بيني وبين ميكائيل، وعلي أمامنا، ومعنا من ملائكة الله ما لا يُحصى عدده، ونحن نلتقط من ذلك الميسم في وجهه من بين الخلائق حتى ينجيهم الله من هول ذلك اليوم وشدائده.
وذلك حكم الله وعطاؤه لمَنْ زار قبرك يا محمد، أو قبر أخيك، أو قبر سبطيك، لا يريد به غير الله (عزّ وجلّ).
وسيجدّ أناس حقّت عليهم من الله اللعنة والسخط؛ أن يعفوا رسم ذلك القبر ويمحوا أثره، فلا يجعل الله تبارك وتعالى لهم إلى ذلك سبيلاً.
ثمّ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فهذا أبكاني وأحزنني.
قالت زينب: فلمّا ضرب ابن ملجم - لعنه الله - أبي (عليه السّلام)، ورأيت أثر الموت منه، قلت له: يا أبه، حدّثتني أُمّ أيمن بكذا وكذا. وقد أحببت أن أسمعه منك. فقال: يا بُنية الحديث كما حدّثتك أُمّ أيمن.
وكأنّي بكِ وببنات أهلكِ سبايا بهذا البلد، أذلاء خاشعين، تخافون أن يتخطّفكم الناس. فصبراً؛ فوالذي فلق الحبّة وبرء النسمة، ما لله على الأرض يومئذٍ ولي غيركم وغير محبّيكم وشيعتكم.
ولقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أخبرنا بهذا الخبر: أنّ إبليس في ذلك اليوم يطير فرحاً، فيجول الأرض كلّها في شياطينه وعفاريته. فيقول: يا معشر الشياطين، قد أدركنا من ذرية آدم الطلِبة، وبلغنا في هلاكهم الغاية، وأورثناهم السوء، إلّا مَنْ اعتصم بهذه العصابة.
فاجعلوا شغلكم بتشكيك الناس فيهم، وحملهم على عداوتهم، وإغرائهم بهم وبأوليائهم؛ حتى تستحكم ضلالة الخلق وكفرهم، ولا ينجو منهم ناجٍ.
( وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ ) (١) . وهو كذوب؛ إنّه لا ينفع مع عداوتكم عمل صالح، ولا يضرّ مع محبّتكم وموالاتكم ذنب غير الكبائر».
قال زائدة: ثمّ قال علي بن الحسين (عليهم السّلام) بعد أن حدّثني بهذا الحديث: «خذه إليك. وأمّا لو ضربت في طلبه آباط الإبل حولاً لكان قليلاً».
____________________
١ - سورة سبأ/٢٠.
* المصادر والمراجع
* محتويات الكتاب
المصادر والمراجع
١- القرآن الكريم.
٢- الآحاد والمثاني: أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني، المعروف بابن عاصم (ت٢٨٧هـ)، الطبعة الأولى، نشر دار الدراية، الرياض، ١٤١١هـ/١٩٩١م، تحقيق د. باسم فيصل أحمد الجوابرة.
٣ -آداب العلماء والمتعلمين: الحسين بن القاسم اليمني الزيدي (ت١٠٥٠هـ)، الطبعة المعتمدة في موقع الموسوعة الشاملة على الشبكة المعلوماتية.
٤ -الإتقان في علوم القرآن: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت٩١١هـ)، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ، طبع ونشر دار الفكر، بيروت، لبنان، تحقيق سعيد المندوب.
٥ -إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات: محمد بن الحسن الحرّ العاملي (ت١١٠٤هـ)، الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م، منشورات مؤسسة الأعلمي، بيروت، لبنان.
٦ -إثبات الوصية: أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي الهذلي، الطبعة الثانية ١٤٠٩هـ/١٩٨٨م، دار الأضواء بيروت، لبنان.
٧ -الأحاديث المختارة: أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد الحنبلي المقدسي (ت٦٤٣هـ)، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ، نشر مكتبة النهضة الحديثة- مكة المكرّمة: تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش.
٨ -الاحتجاج: أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي (ت ٥٦٠هـ)، طبع ونشر منشورات دار النعمان للطباعة والنشر، النجف الأشرف ١٩٦٦م، تحقيق السيد محمد باقر الخرسان.
٩ -الإحكام في أصول الأحكام: ابن حزم الأندلسي الظاهري (ت٤٥٦هـ)، مطبعة العاصمة، القاهرة، الناشر زكريا علي يوسف.
١٠ -أحكام القرآن: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت٣٧٠هـ)، الطبعة الأولى١٤١٥هـ/١٩٩٤م، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق عبد السّلام محمد علي شاهين.
١١ -أحوال الرجال: أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني (ت٢٥٩هـ)، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، تحقيق صبحي السامرائي.
١٢ -الأخبار الطوال: أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري (ت٢٨٢هـ)، الطبعة الأولى ١٩٦٠م، نشر دار إحياء الكتب العربي، عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، تحقيق عبد المنعم عامر.
١٣ -أخبار مكة: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي (ت٢٧٥هـ)، الطبعة الثانية ١٤١٤هـ، نشر دار خضر، بيروت، تحقيق د. عبد الملك عبد الله دهيش.
١٤ -أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي (ت٢٥٠هـ)، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م، تحقيق. د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش.
١٥ -الاختصاص: الشيخ المفيد (ت٤١٣هـ)، الطبعة الثانية ١٤١٣هـ/١٩٩٣م، نشر جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، تحقيق علي أكبر الغفاري - السيد
محمود الزرندي.
١٦ -اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي): الشيخ الطوسي (ت٤٦٠هـ)، مطبعة بعثت، قم ١٤٠٤هـ، نشر مؤسسة آل البيت (عليهم السّلام) لإحياء التراث، تحقيق مير داماد الاسترابادي، السيد مهدي الرجائي.
١٧ -الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل البخاري (ت٢٥٦هـ)، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م، طبع ونشر مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت.
١٨ -الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: الشيخ المفيد (ت٤١٣هـ)، طبع ونشر دار المفيد، الطبعة الثانية ١٩٩٣م، تحقيق مؤسسة آل البيت (عليهم السّلام) لتحقيق التراث.
١٩ -إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، تحقيق زهير الشاويش.
٢٠ -الاستذكار: ابن عبد البر النمري القرطبي (ت٤٦٣هـ)، الطبعة الأولى ٢٠٠٠م، طبع ونشر دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق سالم محمد عطا، محمد علي معوض.
٢١ -الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبد البر النمري القرطبي (ت٤٦٣هـ)، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ، طبع ونشر دار الجيل، بيروت، تحقيق علي محمد البجاوي.
٢٢ -أسد الغابة في معرفة الصحابة: عزّ الدين علي بن أبي الكرم بن الأثير (ت٦٣٠هـ)، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، انتشارات إسماعيليان، طهران.
٢٣ -الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ)، الطبعة الأولى ١٩٩٥م، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد عوض.
٢٤ -أضواء البيان: محمد الأمين الشنقيطي (ت١٣٩٣هـ)، طبع ونشر دار الفكر، ١٤١٥هـ/١٩٩٥م، بيروت، لبنان، تحقيق مكتب البحوث والدراسات.
٢٥ -إعجاز القرآن: أبو بكر محمد بن الطيب (ت٤٠٣هـ)، الطبعة الثالثة، طبع ونشر دار المعارف، مصر، تحقيق السيد أحمد صقر.
٢٦ -الأعلام: خير الدين الزركلي (ت١٤١٠هـ)، الطبعة الخامسة ١٩٨٠م، نشر دار العلم للملايين، بيروت.
٢٧ -أعلام الدين في صفات المؤمنين: الحسن بن أبي الحسن الديلمي (ق٨)، الطبعة الثانية ١٤١٤هـ، نشر وتحقيق مؤسسة آل البيت (عليهم السّلام) لإحياء التراث، قم المقدّسة.
٢٨ -أعلام النساء في عالمي العرب والسّلام: عمر رضا كحالة، الطبعة الثانية ١٣٧٨هـ/١٩٥٩م، المطبعة الهاشمية، دمشق.
٢٩ -إعلام الورى بأعلام الهدى: الفضل بن الحسن الطبرسي (ت٥٤٨هـ)، طبعة ربيع الأوّل ١٤١٧هـ، ستارة، قم، نشر وتحقيق مؤسسة آل البيت (عليهم السّلام) لإحياء التراث، قم المشرّفة.
٣٠ -الأغاني: أبو الفرج الأصفهاني (ت٣٥٦هـ) نسخة مصوّرة عن طبعة دار الكتب، مؤسسة جمال للطباعة والنشر، بيروت، إشراف محمد أبو الفضل إبراهيم.
٣١ -الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين (عليه السّلام): الشيخ المفيد (ت٤١٣هـ)، الطبعة
الأولى ١٤١٢هـ، نشر دار المفيد، بيروت، تحقيق قسم الدراسات الإسلامية، مؤسسة البعثة، قم المقدّسة.
٣٢ -إقبال الأعمال: علي بن موسى بن طاووس (ت٦٤٤هـ)، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ، طبع ونشر مكتب الإعلام الإسلامي، تحقيق جواد القيومي الأصفهاني.
٣٣ -الإمامة والسياسة: أبو محمد عبد الله بن مسلم، ابن قتيبة الدينوري (ت٢٧٦هـ)، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ/١٩٩٧م، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، منشورات محمد علي بيضون، تعليق خليل المنصور.
٣٤ -الأمالي: للشجري، الشهيرة بالأمالي الخميسية، أبو الحسين يحيى بن الموفق بالله أبي عبد الله الحسين بن إسماعيل الجرجاني، عالم الكتب، بيروت، مكتبة المثنى، القاهرة.
٣٥ -أمالي الصدوق: الشيخ الصدوق (ت٣١٨هـ)، الطبعة الأولى١٤١٧هـ، نشر مؤسسة البعثة، تحقيق قسم الدراسات الإسلامية، مؤسسة البعثة، قم.
٣٦ -أمالي الطوسي: محمد بن الحسن الطوسي (ت٤٦٠هـ)، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ، طبع ونشر دار الثقافة، قم، تحقيق قسم الدراسات الإسلامية، مؤسسة البعثة.
٣٧ -أمالي المحاملي برواية ابن يحيى البيع: أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل الضبي المحاملي (ت٣٣٠هـ)، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ، نشر المكتبة الإسلامية، دار ابن القيم، ١٤١٢هـ، تحقيق د. إبراهيم القيسي.
٣٨ -أمالي المرتضى: السيد المرتضى (ت٤٣٦هـ)، الطبعة الأولى ١٣٢٥هـ/ ١٩٠٧م، منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي ١٤٠٣هـ،
تحقيق: السيد محمد بدر الدين النعساني الحلبي.
٣٩ -أمالي المفيد: الشيخ المفيد (ت٤١٣هـ)، الطبعة الثانية ١٩٩٣م، المطبعة الإسلامية، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، قم المقدّسة، تحقيق الحسين أستاد ولي، علي أكبر غفاري.
٤٠ -الإمامة والتبصرة من الحيرة: ابن بابويه القمي (ت٣٢٩هـ)، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ، نشر وتحقيق مدرسة الإمام المهدي (عليه السّلام)، قم المقدّسة.
٤١ -إمتاع الأسماع بما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع: تقي الدين أحمد بن علي المقريزي (ت٨٤٥هـ)، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ١٩٩٩م، تحقيق وتعليق محمد عبد الحميد النميسي.
٤٢ -الأمان من أخطار الأسفار: علي بن موسى بن طاووس (ت٦٦٤هـ)، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ، مطبعة مهر، قم المقدّسة، تحقيق مؤسسة آل البيت (عليهم السّلام) لإحياء التراث.
٤٣ -الأموال: أبو عبيد القاسم بن سلام (ت٢٢٤هـ)، الطبعة الثانية ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م، نشر وطبع دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق محمد خليل هراس.
٤٤ -الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمّة الفقهاء: ابن عبد البر (ت٤٦٣هـ)، طبع ونشر دار الكتب العلمية، بيروت.
٤٥ -الأنساب: أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني (ت٥٦٢هـ)، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ، طبع ونشر دار الجنان، تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي.
٤٦ -أنساب الأشراف: أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري (ت ٢٧٩هـ)، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ/١٩٩٦م، دار الفكر، بيروت، تحقيق د. سهيل زكار، د. رياض زركلي، بإشراف مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
٤٧ -الأنوار النعمانية: السيد نعمة الله الموسوي الجزائري (ت١١١٢هـ)، مطبعة شركة چاب، تبريز، إيران ١٣٧٨هـ.
٤٨ -الأوائل: أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
٤٩ -الإيضاح: الفضل بن شاذان النيسابوري (ت٢٦٠هـ)، نشر مؤسسة جامعة طهران ١٣٦٣ش، تحقيق السيد جلال الدين الحسيني الأرموي.
٥٠ -بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار: المولى محمد باقر المجلسي (ت١١١١هـ)، الطبعة الثانية المصححة ١٩٨٣م، طبع ونشر مؤسسة الوفاء، بيروت، لبنان.
٥١ -البحر الزخار: المعروف بمسند البزار، أبو بكر البزّار (ت٢٩٢هـ)، نشر مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنوّرة، المملكة العربية السعودية ٢٠٠٣م، تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله.
٥٢ -البدء والتاريخ: مطهر بن طاهر المقدسي (ت٥٠٧هـ)، مدينة باريز ١٩١٦م.
٥٣ -بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (ت٥٨٧هـ)، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ، نشر المكتبة الحبيبية، باكستان.
٥٤ -البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (ت٧٧٤هـ)،
الطبعة الأولى ١٩٨٨م، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق علي شيري.
٥٥ -بشارة المصطفى: محمد بن أبي القاسم الطبري الإمامي (من أعلام القرن السادس)، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ، طبع ونشر مؤسسة النشر الإسلامي، تحقيق جواد القيومي الأصفهاني.
٥٦ -بصائر الدرجات: محمد بن حسن بن فروخ الصفار (ت٢٩٠هـ)، طبع مطبعة الأحمدي، طهران، ١٤٠٤هـ، نشر مؤسسة الأعلمي، طهران، تحقيق ميرزا محسن كوجه باغي.
٥٧ -البصائر والذخائر: أبو حيان التوحيدي (ت٤١٤هـ)، مكتبة أطلس ومطبعة الإنشاء، دمشق، تحقيق د. إبراهيم الكيلاني.
٥٨ -بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: أبي الحسن علي بن أبي بكر الهيتمي (ت٨٠٧هـ)، نشر دار الطلائع، القاهرة، تحقيق مسعد عبد الحميد محمد السعدني.
٥٩ -بغية الطلب في تاريخ حلب: ابن العديم كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة (ت٦٦٠هـ)، نشر دار الفكر، بيروت، تحقيق د. سهيل زكار.
٦٠ -بلاغات النساء: أبو الفضل بن أبي طاهر، المعروف بابن طيفور (ت٣٨٠هـ)، نشر مكتبة بصيرتي، قم المقدّسة.
٦١ -تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الواسطي الزبيدي الحنفي (ت١٢٠٥هـ)، طبع ونشر دار الفكر، بيروت، ١٤١٤هـ، تحقيق علي شيري.
٦٢ -تاريخ الإسلام: أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت٧٤٨هـ)، نشر دار
الكتاب العربي بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ١٩٨٧م، تحقيق د. عمر عبد السّلام تدمري.
٦٣ -تاريخ ابن خلدون المسمّى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ..: ابن خلدون المغربي (ت٨٠٨هـ)، نشر مؤسسة الأعلمي، بيروت ١٩٧١م.
٦٤ -تاريخ بغداد: أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت٤٦٣هـ)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٩٩٧م، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا.
٦٥ -تاريخ الخلفاء: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت٩١١هـ)، نشر مطبعة السعادة، مصر، ١٣٧١هـ/١٩٥٢م، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد.
٦٦ -تاريخ خليفة بن خياط أبو عمر خليفة بن خياط الليثي العصفري (ت٢٤٠هـ): نشر دار الفكر، بيروت، ١٩٩٣م، تحقيق د. سهيل زكار.
٦٧ -تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس: حسين بن محمد بن الحسن الدياربكري (ت٩٦٦هـ)، مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان.
٦٨ -تاريخ دمشق: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي، المعروف بابن عساكر (ت ٥٧١هـ)، نشر دار الفكر بيروت، لبنان ١٩٩٥م، دراسة وتحقيق علي شيري.
٦٩ -تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك): محمد بن جرير الطبري (ت٣١٠هـ)، الطبعة الرابعة ١٩٨٣م، نشر مؤسسة الأعلمي، بيروت.
٧٠ -التاريخ القويم: محمد طاهر الكردي المكي، الطبعة الثالثة ١٤٢٥هـ/
٢٠٠٤م، نشر مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، تحقيق د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش.
٧١ -التاريخ الكبير: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت٢٥٦هـ)، نشر المكتبة الإسلامية، ديار بكر، تركي.
٧٢ -تاريخ مختصر الدول: غريغوريوس الملطي، المعروف بابن العبري، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، لبنان ١٩٥٨م.
٧٣ -تاريخ المدينة المنوّرة: عمر بن شبة النميري (ت٢٦٢هـ)، الطبعة الثانية ١٤١٠هـ، مطبعة قدس، قم، نشر دار الفكر، تحقيق فهيم محمد شلتوت.
٧٤ -تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف: أبو البقاء محمد بن أحمد ابن الضياء المكي الحنفي (ت٨٥٤هـ)، الطبعة الثانية ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م، نشر محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق علاء إبراهيم الأزهري، أيمن نصر الأزهري.
٧٥ -تاريخ اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر العباسي، نشر دار صادر، بيروت.
٧٦ -تأويل مختلف الحديث: عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت٢٧٦هـ)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
٧٧ -تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة: أبو نعيم الأصبهاني (ت٤٣٠هـ)، الطبعة المعتمدة على موقع الموسوعة الشاملة في الشبكة المعلوماتية.
٧٨ -التحصين لأسرار ما زاد من أخبار كتاب اليقين: رضي الدين علي بن موسى بن طاووس (٦٦٤هـ)، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ، مطبعة نمونه، نشر مؤسسة دار الكتاب (الجزائري)، تحقيق الأنصاري.
٧٩ -تحف العقول عن آل الرسول (صلّى الله عليهم): ابن شعبة الحراني (ق٤)، طبعة ١٤٠٤هـ، نشر مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين، تحقيق علي أكبر الغفاري.
٨٠ -تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: محمد بن عبد الرحمن المباركفوري (ت١٣٥٣هـ)، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.
٨١ -تحفة الفقهاء: علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي (ت٥٣٩هـ)، الطبعة الثانية ١٤١٤هـ، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.
٨٢ -تخريج الأحاديث والآثار: أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي (ت٧٦٢هـ)، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ، طبع ونشر دار ابن خزيمة، الرياض، تحقيق عبد الله بن عبد الرحمن السعد.
٨٣ -تذكرة الحفاظ: أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت٧٤٨هـ)، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، صحح على نسخة في مكتبة الحرم المكي، تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي.
٨٤ -التذكرة الحمدونية في التاريخ والأدب والنوادر والأشعار: محمد بن الحسن ابن حمدون البغدادي (ت٥٦٢هـ)، الطبعة المعتمدة في المكتبة الشاملة على الشبكة المعلوماتية.
٨٥ -تذكرة الخواص: يوسف بن فرغلي، المعروف بسبط ابن الجوزي (ت٦٥٠هـ)، نشر المكتبة الحيدرية، النجف الأشرف ١٩٦٤م، تقديم السيد محمد صادق بحر العلوم.
٨٦ -ترجمة الإمام الحسن (عليه السّلام) من طبقات ابن سعد: ابن سعد (ت٢٣٠هـ)، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ، نشر مؤسسة آل البيت (عليهم السّلام) لإحياء التراث، قم
المقدّسة، تحقيق السيد عبد العزيز الطباطبائي.
٨٧ -ترجمة الإمام الحسين (عليه السّلام) ومقتله من طبقات ابن سعد: ابن سعد (ت٢٣٠هـ)، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ، نشر مؤسسة آل البيت (عليهم السّلام) لإحياء التراث، قم المقدّسة، تحقيق السيد عبد العزيز الطباطبائي.
٨٨ -الترغيب والترهيب: أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت٦٥٦هـ)، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق إبراهيم شمس الدين.
٨٩ -تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمّة الأربعة: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ)، نشر دار الكتاب العربي، بيروت.
٩٠ -تفسير ابن أبي حاتم: ابن أبي حاتم الرازي (ت٣٢٧هـ)، طبع ونشر صيدا، المكتبة العصرية، تحقيق أسعد محمد الطيب.
٩١ -تفسير البغوي (معالم التنزيل): الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت٥١٦هـ)، طبع ونشر دار المعرفة، بيروت، تحقيق خالد عبد الرحمن العك.
٩٢ -تفسير الثعلبي: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي (ت٤٢٧هـ)، الطبعة الأولى ٢٠٠٢م، طبع ونشر دار إحياء التراث العربي، تحقيق أبي محمد بن عاشور.
٩٣ -تفسير الرازي (التفسير الكبير): محمد بن عمر الفخر الرازي (ت٦٠٦هـ)، الطبعة الثالثة.
٩٤ -تفسير السمعاني: منصور بن محمد السمعاني (ت٤٨٩هـ)، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ، طبع ونشر دار الوطن، الرياض، تحقيق ياسر بن إبراهيم
وغنيم بن عباس بن غنيم.
٩٥ -تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن): أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت٣١٠هـ)، طبعة ١٤١٥هـ، نشر دار الفكر، بيروت، تحقيق صدقي جميل العطار.
٩٦ -تفسير العيّاشي: محمد بن مسعود بن عياش السمرقندي (ت٣٢٠هـ)، نشر المكتبة العلمية الإسلامية، طهران، تحقيق السيد هاشم الرسولي المحلاتي.
٩٧ -تفسير القرآن: عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت٢١١هـ)، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ/١٩٨٩م، نشر مكتبة الرشد، الرياض، تحقيق د. مصطفى مسلم محمد.
٩٨ -تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير): أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت٧٧٤هـ)، طبعة ١٤١٢هـ/١٩٩٢م، نشر دار المعرفة، بيروت، تقديم د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي.
٩٩ -تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت٦٧١هـ)، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت ١٩٨٥م، تحقيق أحمد عبد العليم البردوني.
١٠٠ -تفسير القمي: علي بن إبراهيم القمي (ق ٤)، الطبعة الثالثة ١٤٠٤هـ، نشر مؤسسة دار الكتاب، قم، تعليق السيد طيب الموسوي الجزائري.
١٠١ -تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل...: محمود بن عمر الزمخشري (ت٥٣٨هـ)، نشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، عباس ومحمد ومحمود الحلبي وشركائهم، خلفاء، ١٣٨٥/١٩٦٦م.
١٠٢ -تفسير مقاتل بن سليمان: مقاتل بن سليمان (ت١٥٠هـ)، الطبعة الأولى
١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م، طبع ونشر دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق أحمد فريد.
١٠٣ -تقريب المعارف: أبو الصلاح الحلبي (ت٤٤٧ هـ)، طبع ونشر المحقق، ١٤١٧ هـ، تحقيق: فارس تبريزيات الحسون.
١٠٤ -تقييد العلم: أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت٤٦٣هـ)، الطبعة المعتمدة في موقع الموسوعة الشاملة على الشبكة المعلوماتية.
١٠٥ -تلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ)، نشر دار الفكر، بيروت، لبنان.
١٠٦ -التمهيد: ابن عبد البر النمري (ت٤٦٣هـ)، طبع ونشر المغرب، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، ١٣٨٧هـ، تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري.
١٠٧ -التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: ابن عبد البر النمري (ت٤٦٣هـ)، طبعة ١٣٨٧هـ، نشر وزارة عموم الأوقاف والشؤون الدينية، المغرب، تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري.
١٠٨ -تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين: شرف الإسلام بن سعيد المحسن بن كرامة (ت٤٩٤هـ)، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ، مطبعة محمد، نشر مركز الغدير للدراسات الإسلامية، تحقيق السيد تحسين آل شبيب الموسوي.
١٠٩ -تنزيه الأنبياء: الشريف المرتضى (ت٤٣٦هـ)، الطبعة الثانية ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م، نشر دار الأضواء، بيروت.
١١٠ -تهذيب الأحكام: الشيخ الطوسي (ت٤٦٠هـ)، الطبعة الثالثة ١٣٩٠هـ، مطبعة خورشيد، نشر دار الكتب الإسلامية، تحقيق السيد حسن الموسوي
الخرسان، تصحيح الشيخ محمد الآخوندي.
١١١ -تهذيب الأسماء واللغات: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت٦٧٦هـ)، الطبعة الأولى ١٩٩٦م، نشر دار الفكر، بيروت.
١١٢ -تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ)، الطبعة الأولى ١٩٨٤م، نشر دار الفكر، بيروت.
١١٣ -تهذيب الكمال في أسماء الرجال: أبو الحجاج يوسف المزي (ت٧٤٢هـ)، الطبعة الرابعة ١٩٨٥م، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، تحقيق بشار عواد معروف.
١١٤ -التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: محمد بن عبد الوهاب (ت١٢٠٦هـ)، ملتزم الطبع والنشر، عبد الحميد أحمد حنفي، مصر، تحقيق الشيخ محمد سالم محيسن.
١١٥ -الثاقب في المناقب: ابن حمزة الطوسي (ت٥٦٠هـ)، الطبعة الثانية ١٤١٢هـ، مطبعة الصدر، نشر مؤسسة أنصاريان، قم المقدّسة، تحقيق الأستاذ نبيل رضا علوان.
١١٦ -الثقات: أبو حاتم محمد بن حبان التميمي البستي (ت٣٥٤هـ)، الطبعة الأولى ١٣٩٣هـ، طبع مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند بإشراف د. محمد عبد المعيد خان، نشر مؤسسة الكتب الثقافية.
١١٧ -الثمر الداني في تقريب المعاني: صالح عبد السميع الآبي الأزوري (ت١٣٣٠هـ)، نشر المكتبة الثقافية، بيروت.
١١٨ -ثواب الأعمال: الشيخ الصدوق (ت٣٨١هـ)، الطبعة الثانية ١٣٦٨ش، المطبعة أمير، منشورات الشريف الرضي، قم المقدّسة، تقديم السيد محمد
مهدي السيد حسن الخرسان.
١١٩ -جامع بيان العلم وفضله: ابن عبد البر (ت٤٦٣هـ)، طبع ونشر دار الكتب العلمية، بيروت ١٣٩٨هـ.
١٢٠ -الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت٩١١هـ)، الطبعة الأولى ١٤٠١هـ، نشر دار الفكر، بيروت.
١٢١ -الجرح والتعديل: أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي (ت٣٢٧هـ)، الطبعة الأولى١٩٥٢م، طبع مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الهند، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت.
١٢٢ -جزء الحميري: علي بن محمد الحميري (ت٣٢٣هـ)، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ، نشر دار الطحاوي، حديث أكادمي، الرياض، تحقيق أبو طاهر زبير بن مجدد عليزئي.
١٢٣ -جمهرة خطب العرب: أحمد زكي صفوت، الطبعة الأولى ١٩٣٣م، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
١٢٤ -جوامع السيرة: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري (ت٤٥٦هـ)، الطبعة الأولى، نشر دار المعارف، مصر، تحقيق إحسان عباس.
١٢٥ -جواهر العقدين في فضل الشرفين شرف العلم الجلي والنسب العلي: علي بن عبد الله الحسني السمهودي (ت٩١١هـ)، طبعة ١٤٠٥هـ/١٩٨٤م، مطبعة العاني، بغداد، تحقيق موسى بناي العليلي.
١٢٦ -جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود: محمد بن أحمد المنهاجي
الأسيوطي (ق٩)، الطبعة الأولى١٤١٧هـ/١٩٩٦م، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق مسعد عبد الحميد محمد السعدني.
١٢٧ -جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: الشيخ محمد حسن النجفي (ت١٢٦٦هـ)، الطبعة الثانية ١٣٦٥ش، مطبعة خورشيد، نشر دار الكتب الإسلامية، طهران، تحقيق الشيخ عباس القوجاني.
١٢٨ -الجواهر المضية في طبقات الحنفية: محمد عبد القادر ابن أبي الوفاء القرشي الحنفي المصري (ت ٧٧٥هـ)، الطبعة الأولى ١٣٣٢هـ، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد الدكن، الهند.
١٢٩ -جواهر المطالب في مناقب الإمام علي بن أبي طالب (عليه السّلام): محمد بن أحمد الدمشقي الباعوني الشافعي (ت٨٧١هـ)، طبع دانش ١٤١٥هـ، نشر مجمع إحياء الثقافة الإسلامية، قم المقدّسة، تحقيق الشيخ باقر المحمودي.
١٣٠ -الجوهرة في نسب الإمام علي وآله: محمد بن أبي بكر التلمساني، المعروف بالبري (ت ق ٧هـ)، الطبعة الأولى ١٤٠٢هـ، مطبعة مؤسسة الأعلمي بيروت، نشر مكتبة النوري، دمشق، تحقيق د. محمد التونجي.
١٣١ -حجّة الوداع: ابن حزم الأندلسي (ت٤٥٦هـ)، الطبعة المعتمدة في موقع الموسوعة الشاملة على الشبكة المعلوماتية.
١٣٢ -حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبدالله الشافعي (ت٤٣٠ هـ)، الطبعة الأولى ١٩٩٧م، دار الكتب العلمية، بيروت.
١٣٣ -حياة الحيوان: كمال الدين محمد بن موسى الدميري (ت٨٠٨هـ)، نشر دار التحرير ١٩٦٥م.
١٣٤ -الحيوان: عمرو بن بحر الجاحظ (ت٢٥٥ هـ) دار إحياء التراث العربي -
بيروت، تحقيق وشرح عبد السّلام محمد هارون.
١٣٥ -الخرائج والجرائح: قطب الدين الراوندي (ت٥٧٣هـ)، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ، المطبعة العلمية، نشر وتحقيق مؤسسة الإمام المهدي (عليه السّلام)، قم المقدّسة.
١٣٦ -خزانة الأدب: عبد القادر بن عمر البغدادي الحنفي (ت١٠٩٣هـ)، الطبعة الأولى ١٩٩٨م، طبع ونشر دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق محمد نبيل طريفي، إميل بديع اليعقوب.
١٣٧ -خصائص الأئمّة: الشريف الرضي (ت٤٠٦هـ)، نشر مجمع البحوث الإسلامية، مشهد، إيران، ١٤٠٦هـ، تحقيق د. محمد هادي الأميني.
١٣٨ -الخصال: الشيخ الصدوق (ت٣٨١هـ)، نشر جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، قم المقدّسة، ١٤٠٣هـ، تحقيق علي أكبر الغفاري.
١٣٩ -الدراية في تخريج أحاديث الهداية: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ)، طبع ونشر دار المعرفة، بيروت، تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني المدني.
١٤٠ -الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطي (ت٩١١هـ)، نشر دار الفكر، بيروت، لبنان.
١٤١ -الدرّ النظيم: ابن حاتم العاملي (ت٦٦٤هـ)، نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم المقدّسة.
١٤٢ -دعائم الإسلام: نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون التميمي المغربي (ت٣٦٣هـ)، نشر دار المعارف، مصر ١٣٨٣هـ/١٩٦٣م، تحقيق آصف بن علي أصغر فيضي.
١٤٣ -دلائل الإمامة: أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري (توفي في أوائل القرن الرابع الهجري)، الطبعة الأولى١٤١٣هـ، نشر مؤسسة البعثة، تحقيق قسم الدراسات الإسلامية، مؤسسة البعثة، قم.
١٤٤ -ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: محبّ الدين أحمد بن عبد الله الطبري (ت٦٩٤هـ) عن نسخة دار الكتب المصرية ونسخة الخزانة التيمورية، نشر مكتبة القدسي، القاهرة ١٣٥٦هـ.
١٤٥ -ذكر أخبار إصبهان: أحمد بن عبد الله أبو نعيم الإصبهاني (ت٤٣٠هـ)، مطبعة بريل، ليدن المحروسة، ١٩٣٤م.
١٤٦ -ذكر مَنْ اسمه شعبة: أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران أبو نعيم الأصبهاني (ت٤٣٠هـ)، الطبعة الأولى ١٩٩٧م، نشر مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنوّرة، تحقيق طارق محمد سلكوع العمودي.
١٤٧ -ذيل تاريخ بغداد: ابن النجار البغدادي (ت٦٤٣هـ)، الطبعة الأولى ١٩٩٧م، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا.
١٤٨ -ربيع الأبرار ونصوص الأخبار: محمود بن عمر الزمخشري (ت٥٣٨هـ)، مطبعة العاني، بغداد، تحقيق د. سليم النعيمي.
١٤٩ -روح البيان: إسماعيل حقي بن مصطفى الحنفي الخلوتي البروسوي (ت١١٢٧هـ)، نشر دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ٢٠٠٣م، ضبط عبد اللطيف حسن عبد الرحمن.
١٥٠ -روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: المعروف بـ (تفسير الآلوسي)، أبو الفضل شهاب الدين محمود الألوسي (ت١٢٧٠هـ).
١٥١ -روضة الواعظين: محمد بن الفتال النيسابوري الشهيد (ت٥٠٨هـ)، نشر منشورات الرضي، قم، إيران، تحقيق السيد محمد مهدي السيد حسن الخرسان.
١٥٢ -الروض المعطار في خبر الأقطار: محمد بن عبد المنعم الصناهجي الحميري (ت٧٢٧هـ)، الطبعة الثانية ١٩٨٠م، دار السراج، نشر مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت، تحقيق إحسان عباس.
١٥٣ -الرياض النضرة في مناقب العشرة: أبو جعفر أحمد، الشهير بالمحبّ الطبري (ت٦٩٤هـ)، الطبعة الثانية ١٣٧٢هـ/١٩٥٣م، مطبعة دار التأليف، مصر.
١٥٤ -زاد المعاد في هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، الشهير بابن قيم الجوزية (ت٧٥١هـ)، الطبعة المعتمدة في موقع الإسلام على الشبكة المعلوماتية.
١٥٥ -الزهد: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت٢٤١هـ)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ١٣٩٨هـ.
١٥٦ -سبل السّلام: محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني الأمير (ت١١٨٢هـ)، الطبعة الرابعة ١٣٧٩هـ، نشر مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، تحقيق محمد عبد العزيز الخولي.
١٥٧ -سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد: محمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت٩٤٢هـ)، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض.
١٥٨ -سعد السعود: رضي الدين علي بن موسى بن طاووس (ت٦٦٤هـ)، منشورات الرضي، مطبعة أمير، قم المقدّسة، ١٣٦٣.
١٥٩ -سفر السعادة: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي صاحب القاموس (ت٨٢٦هـ)، دار العصور قوبلت على نسخة مطبوعة بمصر ١٣٣٢هـ.
١٦٠ -السُنّة: أبو بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك (ت٢٨٧هـ)، الطبعة الثالثة ١٤١٣هـ، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني.
١٦١ -السُنّة لعبد الله بن أحمد بن حنبل: عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني (ت٢٩٠هـ)، الطبعة الأولى، نشر دار ابن القيم، الدمام، ١٤٠٦هـ، تحقيق د. محمد سعيد سالم القحطاني.
١٦٢ -سنن ابن ماجة: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت٢٧٥هـ)، نشر دار الفكر، بيروت، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
١٦٣ -سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت٢٧٥هـ)، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ/١٩٩٠م، نشر دار الفكر، تحقيق وتعليق سعيد محمد اللحام.
١٦٤ -سنن الترمذي (الجامع الصحيح): أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت٢٧٩هـ)، الطبعة الثانية ١٩٨٣م، نشر دار الفكر، بيروت، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف.
١٦٥ -سنن الدارقطني: أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي (ت٣٨٥هـ)، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ/١٩٩٦م، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، تعليق مجدي بن منصور بن سيد الشورى.
١٦٦ -سنن الدارمي: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت٢٥٥هـ)، الطبعة الأولى ١٣٤٩هـ، مطبعة الاعتدال، دمشق، طبع بعناية محمد أحمد دهمان.
١٦٧ -السنن الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت٤٥٨هـ)، طبع مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد الدكن، الهند، نشر دار الفكر.
١٦٨ -السنن الكبرى: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت٣٠٣هـ)، الطبعة الأولى ١٤١١هـ، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق د. عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن.
١٦٩ -سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي: عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي المكي (ت١١١١هـ)، المطبعة السلفية، القاهرة ١٣٧٩هـ.
١٧٠ -سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت٧٤٨هـ)، الطبعة التاسعة ١٤١٣هـ، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، تحقيق شعيب الأرناؤوط.
١٧١ -السيرة الحلبية (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون): علي بن برهان الدين الحلبي (ت١٠٤٤هـ)، طبع ونشر دار المعرفة، بيروت، ١٤٠٠هـ.
١٧٢ -السيرة النبوية: أبي الفداء إسماعيل بن كثير (ت٧٧٤هـ)، نشر دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٦هـ/١٩٧٦م، تحقيق مصطفى عبد الواحد.
١٧٣ -السيرة النبوية: عبد الملك بن هشام الحميري (ت٢١٨هـ)، الطبعة الأولى ١٣٨٣هـ، مطبعة المدني، نشر مكتبة محمد علي صبيح وأولاده، مصر، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد.
١٧٤ -الشافي في الإمامة: الشريف المرتضى (ت٤٣٦هـ)، الطبعة الثانية ١٤١٠هـ، طبع ونشر مؤسسة إسماعليان، قم المقدّسة، تحقيق السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب.
١٧٥ -شرح إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل: القاضي الشهيد السيد نور الله الحسيني المرعشي (ت١٠١٩هـ)، منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، قم، تعليق شهاب الدين النجفي المرعشي (ت١٤١١هـ)، تصحيح إبراهيم الميانجي.
١٧٦ -شرح صحيح مسلم: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي (ت٦٧٦هـ)، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٧هـ.
١٧٧ -شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي (ت٧٩٢هـ)، الطبعة الرابعة ١٣٩١هـ، طبع ونشر المكتب الإسلامي، بيروت.
١٧٨ -الشرح الكبير: عبد الرحمن بن قدامة المقدسي (ت٦٨٢هـ)، طبعة بالأوفست، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
١٧٩ -شرح معاني الآثار: أحمد بن محمد بن سلمة الطحاوي (ت٣٢١هـ)، الطبعة الثالثة ١٤١٦هـ، نشر دار الكتب العلمية، تحقيق محمد زهري النجار.
١٨٠ -شرح المقاصد في علم الكلام: مسعود بن عمر التفتازاني (ت٧٩١هـ)، الطبعة الأولى ١٤٠١هـ، طبع ونشر دار المعارف النعمانية، باكستان.
١٨١ -شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد (ت٦٥٦هـ)، الطبعة الأولى ١٩٥٩م، نشر دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم.
١٨٢ -شعب الإيمان: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت٤٥٨هـ)، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول.
١٨٣ -شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام: محمد بن أحمد بن علي الفاسي المكي المالكي (ت٨٣٢هـ)، الطبعة الثانية ١٩٩٩م، نشر مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، باب العمرة، تحقيق د. مصطفى محمد الذهبي.
١٨٤ -شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في الآيات النازلة في أهل البيت: عبيد الله بن أحمد الحاكم الحسكاني (ق٥)، الطبعة الأولى ١٤١١هـ، نشر مجمع إحياء الثقافة الإسلامية، تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي.
١٨٥ -صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: أبو حاتم محمد بن حبان التميمي (ت٣٥٤هـ)، الطبعة الثانية ١٤١٤هـ، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، تحقيق شعيب الأرناؤوط.
١٨٦ -صحيح ابن خزيمة: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري (ت٣١١هـ)، الطبعة الثانية ١٤١٢هـ، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، تحقيق وتعليق د. محمد مصطفى الأعظمي.
١٨٧ -صحيح البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت٢٥٦هـ)، نشر دار الفكر، بيروت ١٤٠١هـ، طبعت بالأوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة بإستانبول.
١٨٨ -صحيح مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجّاج النيسابوري (ت٢٦١هـ)، نشر دار الفكر، بيروت، لبنان.
١٨٩ -الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم: علي بن يونس العاملي النباطي (ت٨٧٧هـ)، الطبعة الأولى١٣٨٤هـ، مطبعة الحيدري، نشر المكتبة الرضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تحقيق محمد باقر البهبودي.
١٩٠ -الصواعق المحرقة في الردّ على أهل البدع والزندقة: أحمد بن حجر الهيتمي (ت٩٧٤هـ)، منشورات محمد علي بيضون، طبعة ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م، دار
الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
١٩١ -الضعفاء: أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي (ت٣٢٢هـ)، الطبعة الثانية١٤١٨هـ، منشورات محمد علي بيضون، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق د.عبد المعطي أمين قلعجي.
١٩٢ -الضعفاء والمتروكين: أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد الجوزي (ت٥٧٩هـ)، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق عبد الله القاضي.
١٩٣ -الطبقات الكبرى: محمد بن سعد البصري (ت٢٣٠هـ)، طبع ونشر دار صادر، بيروت.
١٩٤ -الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: رضي الدين علي بن موسى بن طاووس الحسني (ت٦٦٤هـ)، الطبعة الأولى ١٣٩٩، طبع الخيام، قم.
١٩٥ -الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: رضي الدين علي بن موسى ابن طاووس الحسني (ت ٦٦٤ هـ)، الطبعة الأولى ١٣٩٩، طبع الخيام - قم.
١٩٦ -العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل: محمد بن عقيل العلوي (ت١٣٥٠هـ)، نشر الهدف للإعلام والنشر، تعليق صالح الورداني.
١٩٧ -العظمة: عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني (ت٣٦٩هـ)، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ، نشر دار العاصمة، الرياض، تحقيق رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري.
١٩٨ -العقد الفريد: أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربّه الأندلسي (ت٣٢٨هـ)، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، شرحه وضبط ورتّب فهارسه إبراهيم
الأبياري، قدّم له د. عمر عبد السلام تدمري.
١٩٩ -علل الدارقطني: أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي (ت٣٨٥هـ)، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ، طبع ونشر دار طيبة، الرياض، تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي.
٢٠٠ -علل الشرائع: الشيخ الصدوق (ت٣٨١هـ)، طبع ونشر المكتبة الحيدرية، النجف الأشرف، ١٣٨٦هـ/١٩٦٦م، تقديم السيد محمد صادق بحر العلوم.
٢٠١ -العمدة: ابن البطريق يحيى بن الحسن الأسدي الحلّي (توفي في ٦٠٠هـ تقريباً)، طبع وتحقيق جامعة المدرسين، قم، ١٤٠٧هـ، نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم.
٢٠٢ -عمدة القارئ شرح صحيح البخاري: بدر الدين محمود بن أحمد العيني (ت٨٥٥هـ)، طبع ونشر دار إحياء التراث العربي، بيروت.
٢٠٣ -عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال: الشيخ عبد الله بن نور الله البحراني (ت١١٣٠هـ)، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ، مطبعة أمير، قم، نشر وتحقيق مدرسة الإمام المهدي (عليه السّلام)، قم.
٢٠٤ -عون المعبود شرح سنن أبي داود: محمد شمس الحقّ العظيم آبادي، الطبعة الثانية ١٤١٥هـ، طبع ونشر دار الكتب العلمية، بيروت.
٢٠٥ -عيون الأخبار: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت٢٧٦هـ)، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ١٩٢٥م.
٢٠٦ -عيون أخبار الرضا: الشيخ الصدوق (ت٣٨١هـ)، طبع ونشر مؤسسة الأعلمي، بيروت، لبنان ١٩٨٤م، تحقيق الشيخ حسين الأعلمي.
٢٠٧ -عيون الأنباء في طبقات الأطباء: ابن أبي أصبيعة (ت٦٦٨هـ)، طبع ونشر دار مكتبة الحياة، بيروت، تحقيق د. نزار رضا.
٢٠٨ -غاية الأماني في أخبار القطر اليماني: يحيى بن الحسين بن القاسم (ت١١٠٠هـ)، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة ١٩٦٨م، تحقيق وتقديم سعيد عبد الفتاح عاشور.
٢٠٩ -الغدير في الكتاب والسُنّة والأدب: الشيخ عبد الحسين أحمد الأميني، الطبعة الرابعة ١٣٩٧هـ/١٩٧٧م، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
٢١٠ -غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب: محمد بن أحمد بن سالم السفاريني، الطبعة الثانية ١٤١٤هـ/١٩٩٣م، نشر مؤسسة قرطبة.
٢١١ -الغرر البهية في شرح البهجة الوردية: الشيخ زكريا الأنصاري، طبع بالمطابع الميمنية بمصر.
٢١٢ -الغيبة: الشيخ الطوسي (ت٤٦٠هـ)، الطبعة الأولى ١٤١١هـ، المطبعة بهمن، نشر مؤسسة المعارف الإسلامية، قم المقدّسة، تحقيق الشيخ عباد الله الطهراني والشيخ علي أحمد ناصح.
٢١٣ -الغيبة: محمد بن إبراهيم النعماني (ت٣٦٠هـ)، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ، المطبعة مهر، نشر أنوار الهدى، قم المقدّسة، تحقيق فارس حسون كريم.
٢١٤ -الفائق في غريب الحديث: محمود بن عمر الزمخشري (ت٥٣٨هـ)، الطبعة الأولى ١٩٩٦م، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، تحقيق إبراهيم شمس الدين.
٢١٥ -فتح الباري في شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ)،
الطبعة الثانية، طبع ونشر دار المعرفة، بيروت.
٢١٦ -الفتن: نعيم بن حماد المروزي (ت٢٢٩هـ)، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ، نشر دار الفكر، بيروت١٤١٤هـ/١٩٩٣م، تحقيق د. سهيل زكار.
٢١٧ -الفتوح: أبو محمد أحمد بن أعثم الكوفي (ت٣١٤هـ/٩٢٦م)، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م، طبع ونشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
٢١٨ -فتوح البلدان: أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري (ت٢٧٩هـ)، مطبعة لجنة البيان العربي، ١٩٥٦م، نشر مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، تحقيق د. صلاح الدين المنجد.
٢١٩ -الفخري في الآداب السلطانية: محمد بن علي بن طباطبا، المعروف بابن الطقطقي، مطبعة الكلية الملكية، غريفزولد، ١٨٥٨م.
٢٢٠ -الفردوس بمأثور الخطاب: أبو شجاع شيرويه بن شهرادر بن شيرويه الديلمي الهمذاني (ت٥٠٩هـ)، الطبعة الأولى ١٩٨٦م، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول.
٢٢١ -الفصول المهمة في معرفة الأئمّة: علي بن محمد بن أحمد المالكي، الشهير بابن الصباغ (ت٨٥٥هـ)، الطبعة الأولى ١٤٢٢، مطبعة سرور، نشر دار الحديث، قم، تحقيق سامي الغريري.
٢٢٢ -فضائل أمير المؤمنين (عليه السّلام): ابن عقدة الكوفي (ت٣٣٣هـ)، جمع عبد الرزاق محمد حسين فيض الدين.
٢٢٣ -فضائل الأوقات: أحمد بن الحسين البيهقي (ت٤٥٨هـ)، الطبعة الأولى١٤١٠هـ، طبع ونشر مكتبة المنارة، دراسة وتحقيق عدنان عبد
الرحمن مجيد القيسي.
٢٢٤ -فضائل الصحابة: أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ت ٢٤١هـ)، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، تحقيق د. وصي الله محمد عباس.
٢٢٥ -فقه السُنّة: الشيخ سيد سابق، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
٢٢٦ -الفقيه والمتفقه: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت٤٦٢هـ)، نشر دار ابن الجوزي، السعودية ١٤٢١هـ، تحقيق أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي.
٢٢٧ -فوات الوفيات: محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي (ت٧٦٤هـ)، الطبعة الأولى ٢٠٠٠م، طبع ونشر دار الكتب العلمية، تحقيق علي محمد بن يعوض الله، عادل أحمد عبد الموجود.
٢٢٨ -فيض القدير شرح الجامع الصغير: محمد عبد الرؤوف المناوي (ت١٠٣١هـ)، الطبعة الأولى ١٩٩٤م، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ضبطه وصححه أحمد عبد السلام.
٢٢٩ -الكافي: الشيخ الكليني (ت٣٢٩هـ)، الطبعة الخامسة، نشر دار الكتب الإسلامية، طهران ١٣٨٨هـ، تحقيق علي أكبر غفاري.
٢٣٠ -الكامل: أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، مطبعة نهضة مصر، الفجالة، القاهرة، تعليق محمد أبو الفضل إبراهيم، السيد شحاته.
٢٣١ -كامل الزيارات: الشيخ جعفر بن محمد بن قولويه القمي (ت٣٦٧هـ)، طبع مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ، نشر مؤسسة نشر الفقاهة، تحقيق الشيخ جواد قيومي.
٢٣٢ -الكامل في التاريخ: محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني، المعروف بابن الأثير (ت٦٣٠هـ)، نشر دار صادر، دار بيروت، ١٩٦٥م.
٢٣٣ -الكامل في ضعفاء الرجال: عبد الله بن عدي الجرجاني (ت٣٦٥هـ)، الطبعة الثالثة ١٤٠٩هـ، نشر دار الفكر، بيروت، تحقيق يحيى مختار غزاوي.
٢٣٤ -كتاب سليم بن قيس الهلالي: أبو صادق سليم بن قيس الهلالي العامري الكوفي (توفي في القرن الأوّل)، تحقيق الشيخ محمد باقر الأنصاري الزنجاني.
٢٣٥ -كتاب الصناعتين الكتابة والشعر: أبو هلال الحسين بن عبد الله العسكري، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه ١٩٧١م، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم.
٢٣٦ -الكتاب المقدّس (العهد الجديد): مجمع الكنائس الشرقية، الطبعة الثانية ١٩٨٨م، نشر دار المشرق، بيروت، لبنان.
٢٣٧ -كشاف القناع: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت١٠٥١هـ)، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ/١٩٩٧م، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، تقديم كمال عبد العظيم العناني، تحقيق أبو عبد الله محمد حسن محمد حسن الشافعي.
٢٣٨ -كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمّا اشتهر من الأحاديث على السُنّة الناس: إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي (ت١١٦٢هـ)، الطبعة الثالثة ١٤٠٨هـ، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.
٢٣٩ -كشف الغمة في معرفة الأئمّة: علي بن عيسى بن أبي الفتح الأربلي (ت٦٩٣هـ)، طبع ونشر دار الأضواء، بيروت، الطبعة الثانية ١٩٨٥م.
٢٤٠ -كشف المحجّة لثمرة المهجة: رضي الدين علي بن موسى بن طاووس (ت٦٦٤هـ)، منشورات المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، ١٣٧٠هـ/١٩٥٠م.
٢٤١ -كفاية الأثر في النصّ على الأئمّة الاثني عشر: علي بن محمد الخزاز القمي الرازي (ت٤٠٠هـ)، طبع الخيام، قم، ١٤٠١هـ، نشر انتشارات بيدار، تحقيق السيد عبد اللطيف الحسيني الكوهكمري الخوئي.
٢٤٢ -كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب (عليه السّلام): محمد بن يوسف بن محمد القرشي الكنجي الشافعي (ت٦٥٨هـ)، الطبعة الثانية ١٣٩٠هـ/١٩٧٠م، منشورات المطبعة الحيدرية، النجف، تحقيق محمد هادي الأميني.
٢٤٣ -كمال الدين وتمام النعمة: الشيخ الصدوق (ت٣٨١هـ)، طبع ١٤٠٥هـ، نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم المقدّسة، تحقيق وتصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري.
٢٤٤ -كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: علي المتقي الهندي (ت٩٧٥هـ)، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٩م، بيروت، تحقيق الشيخ بكري حياني والشيخ صفوة السف.
٢٤٥ -اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: الحافظ جلال الدين السيوطي (ت٩١١هـ)، طبعة دار الكتب العلمية.
٢٤٦ -لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور المصري (ت٧١١هـ)، نشر أدب الحوزة، ١٤٠٥هـ، قم المقدّسة.
٢٤٧ -لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ)، الطبعة الثانية ١٣٩٠هـ، نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت.
٢٤٨ -اللهوف في قتلى الطفوف: رضي الدين علي بن موسى بن طاووس (ت٦٦٤هـ)، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ، نشر أنوار الهدى، قم، إيران.
٢٤٩ -المبسوط: شمس الدين السرخسي الحنفي (ت٤٨٣هـ)، نشر دار المعرفة، بيروت، لبنان، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.
٢٥٠ -مثير الأحزان: ابن نما الحلّي (ت٦٤٥هـ)، نشر المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، ١٣٦٩هـ، ١٩٥٠م.
٢٥١ -المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: أبو حاتم محمد بن حبان التميمي (ت٣٥٤هـ)، نشر دار الباز، مكة المكرمة، تحقيق محمود إبراهيم زايد.
٢٥٢ -مجمع البيان في تفسير القرآن: أمين الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسي (ت٥٤٨هـ)، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ، نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، تحقيق لجنة من العلماء والمحققين الأخصائين.
٢٥٣ -مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي (ت٨٠٧هـ)، طبعة ١٩٨٨هـ، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
٢٥٤ -المجموع في شرح المهذب: محيي الدين بن شرف النووي (ت٦٧٦هـ)، نشر دار الفكر.
٢٥٥ -المحاسن: أحمد بن محمد بن خالد البرقي (ت٢٧٤هـ)، نشر دار الكتب الإسلامية، طهران ١٣٧٠هـ، تحقيق السيد جلال الدين الحسيني.
٢٥٦ -المحاسن والمساوئ: إبراهيم بن محمد البيهقي (ق٥)، مطبعة السعادة، مصر ١٩٠٦م.
٢٥٧ -المحبر: محمد بن حبيب البغدادي (ت٢٤٥هـ)، مطبعة مجلس دائرة
المعارف العثمانية ١٣٦١هـ، تحقيق محمد حميد الله.
٢٥٨ -المحلّى: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (ت٤٥٦هـ)، نشر دار الفكر، قوبلت على النسخة التي حقّقها الشيخ أحمد محمد شاكر.
٢٥٩ -المختصر في أخبار البشر (تاريخ أبي الفداء): أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي الدويني صاحب حماة (ت٧٣٢هـ)، الطبعة الأولى، المطبعة الحسينية، مصر.
٢٦٠ -مدينة المعاجز: السيد هاشم البحراني (ت١١٠٧هـ)، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ، مطبعة بهمن، نشر مؤسسة المعارف الإسلامية، قم المقدّسة.
٢٦١ -المراجعات: السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي (ت١٣٧٧هـ)، الطبعة الثانية ١٤٠٢هـ، طبع على نفقة الجمعية الإسلامية، تحقيق وتعليق حسين الراضي.
٢٦٢ -مروج الذهب ومعادن الجوهر: أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي (ت٣٤٥هـ)، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م، طبع ونشر دار الفكر، بيروت، تحقيق وتعليق سعيد محمد اللحام، وطبعة بولاق، مصر ١٢٨٣هـ، والطبعة الأولى من المطبعة الأزهرية المصرية عام ١٣٠٣هـ وبهامشه تاريخ روض المناظر لابن شحنة، وطبعة المروج التي بهامش الكامل في التاريخ.
٢٦٣ -المزار: الشيخ المفيد (ت٤١٣هـ)، الطبعة الثانية ١٤١٤هـ/١٩٩٣م، نشر دار المفيد، بيروت، تحقيق السيد محمد باقر الأبطحي.
٢٦٤ -المزار: الشيخ محمد بن المشهدي (ت ٦٤٥هـ)، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ، مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي، نشر القيوم، قم، تحقيق جواد القيومي الأصفهاني.
٢٦٥ -مسائل الإمام أحمد: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت٢٤١هـ)، الطبعة الأولى ١٩٨٨م، نشر الدار العلمية، دلهي، تحقيق د. فضل الرحمن دين محمد.
٢٦٦ -مسار الشيعة في مختصر تواريخ الشريعة: الشيخ المفيد (ت٤١٣هـ)، الطبعة الثانية ١٤١٤هـ/١٩٩٣م، نشر دار المفيد، بيروت، تحقيق الشيخ مهدي نجف.
٢٦٧ -المسترشد في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السّلام): محمد بن جرير بن رستم الطبري الإمامي (ق ٤)، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ، مطبعة سلمان الفارسي، قم، نشر مؤسسة الثقافة الإسلامية لكوشانبور، تحقيق أحمد المحمودي.
٢٦٨ -المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت٤٠٥هـ)، الطبعة الأولى ١٤١١هـ، نشر دار المعرفة، بيروت، لبنان، طبعة مزيدة بإشراف د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي.
٢٦٩ -مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل: المحقق النوري الطبرسي (ت١٣٢٠هـ)، الطبعة الأولى المحققة ١٤٠٨هـ/١٩٨٧م، نشر وتحقيق مؤسسة آل البيت (عليهم السّلام) لإحياء التراث.
٢٧٠ -مسند ابن الجعد: علي بن الجعد الجوهري (ت٢٣٠هـ)، برواية أبي القاسم البغوي (ت٣١٧هـ)، الطبعة الثانية ١٤١٧هـ/١٩٩٦م، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق الشيخ عامر أحمد حيدر.
٢٧١ -مسند أبي داود الطيالسي: سليمان بن داود الطيالسي (ت٢٠٤هـ)، نشر دار المعرفة، بيروت.
٢٧٢ -مسند أبي عوانة: أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الأسفرائيني (ت٣١٦هـ)،
الطبعة الأولى، نشر دار المعرفة، بيروت، ١٩٩٨م، تحقيق أيمن بن عارف الدمشقي.
٢٧٣ -مسند أبي يعلى: أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي (ت٣٠٧هـ)، نشر دار المأمون للتراث، دمشق، تحقيق حسين سليم أسد.
٢٧٤ -مسند أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل الشيباني (ت٢٤١هـ)، نشر دار صادر، بيروت، لبنان.
٢٧٥ -مسند الإمام زيد بن علي: الشهيد زيد بن علي بن الحسين (١٢٢هـ)، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان.
٢٧٦ -مسند الحميدي: عبد الله بن الزبير الحميدي (ت٢١٩هـ)، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ/١٩٨٨م، دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
٢٧٧ -مسند الشاشي: أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي (ت٣٣٥هـ)، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ، نشر مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنوّرة، تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله.
٢٧٨ -مسند الشاميين: سليمان بن أحمد الطبراني (ت٣٦٠هـ)، الطبعة الثانية١٤١٧هـ، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي.
٢٧٩ -مسند عبد بن حميد (المنتخب من مسند عبد بن حميد): عبد بن حميد بن نصر (ت٢٤٩هـ)، الطبعة الأولى ١٩٨٨م، نشر عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، تحقيق صبحي السامرائي ومحمود محمد خليل الصعيدي.
٢٨٠ -مصباح الزائر: رضي الدين علي بن موسى بن طاووس (ت٦٦٤هـ)،
الطبعة الأولى ١٤١٧هـ، مطبعة ستارة، قم، نشر وتحقيق مؤسسة آل البيت (عليهم السّلام) لإحياء التراث.
٢٨١ -مصباح الزجاجة: أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني (ت٨٤٠هـ)، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ، نشر دار العربية، بيروت، تحقيق محمد المنتقى الكشناوي.
٢٨٢ -مصباح المتهجد: الشيخ الطوسي (ت٤٦٠هـ)، طبع ١٤١١هـ/١٩٩١م، نشر مؤسسة فقه الشيعة، بيروت، لبنان.
٢٨٣ -المصنّف: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي (ت٢٣٥هـ)،الطبعة الأولى ١٩٨٩م، نشر دار الفكر، بيروت، لبنان، تحقيق وتعليق سعيد اللحام.
٢٨٤ -المصنّف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت٢١١هـ)، منشورات المجلس العلمي، تحقيق المحدث حبيب الرحمن الأعظمي.
٢٨٥ -مطالب السؤول في مناقب آل الرسول: محمد بن طلحة الشافعي (ت٦٥٢هـ)، تحقيق ماجد بن أحمد العطية.
٢٨٦ -المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: ابن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢ هـ)، بتنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري، الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ، نشر: دار العاصمة، دار الغيث - السعودية.
٢٨٧ -معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول: محمد بن يوسف الزرندي (ت٧٥٠هـ)، تحقيق ماجد بن أحمد العطية.
٢٨٨ -المعارف: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت٢٧٦هـ)، طبع ونشر دار المعارف، القاهرة، تحقيق د. ثروت عكاشة.
٢٨٩ -معاني الأخبار: الشيخ الصدوق (ت٣٨١هـ)، طبع انتشارات إسلامي،
١٣٦١هـ، نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم المقدّسة، تحقيق علي أكبر الغفاري.
٢٩٠ -المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد الطبراني (ت٣٦٠هـ)، طبعة ١٤١٥هـ، نشر دار الحرمين، تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد وعبد الحسن بن إبراهيم الحسيني.
٢٩١ -معجم البلدان: ياقوت الحموي الرومي البغدادي (ت٦٢٦هـ)، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ١٣٩٩هـ.
٢٩٢ -المعجم الصغير: سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني (ت٣٦٠هـ)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.
٢٩٣ -المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني (ت٣٦٠هـ)، الطبعة الثانية، نشر دار إحياء التراث العربي، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي.
٢٩٤ -معجم ما استعجم: عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي (ت٤٨٧هـ)، نشر عالم الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة ١٩٨٣م، تحقيق مصطفى السقا.
٢٩٥ -معرفة السنن والآثار: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت٤٥٨هـ)، طبع ونشر دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق سيد كسروي حسن.
٢٩٦ -المعرفة والتاريخ: أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي (ت٢٧٧هـ)، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٠١هـ، تحقيق د. أكرم ضياء العمري.
٢٩٧ -المغني: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت٦٢٠هـ)، طبعة أوفست، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
٢٩٨ -مقاتل الطالبيين: أبو الفرج الأصفهاني (ت٣٥٦هـ)، الطبعة الثانية
١٩٦٥م، منشورات المكتبة الحيدرية، النجف الأشرف، تقديم كاظم المظفر.
٢٩٩ -مقتل الحسين: الموفق بن أحمد الخوارزمي (ت٥٦٨هـ)، مطبعة الزهراء، النجف الأشرف ١٩٤٨م، تعليق الشيخ محمد السماوي.
٣٠٠ -مقدّمة ابن خلدون: عبد الرحمن ابن خلدون المغربي (ت٨٠٨هـ)، الطبعة الرابعة، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت.
٣٠١ -الملاحم والفتن (التشريف بالمنن في التعريف بالفتن): رضي الدين علي بن موسى بن طاووس (ت٦٦٤هـ)، الطبعة الأولى١٤١٦هـ، طبع نشاط، أصفهان، نشر وتحقيق مؤسسة صاحب الأمر (عجّل الله فرجه).
٣٠٢ -ملحقات إحقاق الحقّ: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي (ت١٤١١هـ)، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ، مطبعة حافظ، قم، منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، تحقيق السيد محمود المرعشي.
٣٠٣ -المناقب: الموفق بن أحمد الخوارزمي (ت٥٦٨هـ)، الطبعة الثانية ١٤١١هـ، طبع ونشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم، تحقيق الشيخ مالك المحمودي.
٣٠٤ -مناقب آل أبي طالب: ابن شهرآشوب (ت٥٨٨هـ)، طبع المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، ١٣٧٦هـ، تحقيق لجنة من أساتذة النجف الأشرف.
٣٠٥ -مناقب أبي حنيفة: الموفق بن أحمد الخوارزمي، الطبعة الأولى، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد الدكن، الهند.
٣٠٦ -مناقب أبي حنيفة: محمد بن محمد بن شهاب، المعروف بابن البزاز الكردري الحنفي (ت٨٢٧هـ)، الطبعة الأولى، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية،
حيدر آباد الدكن، الهند.
٣٠٧ -المنتخب من ذيل المذيل: محمد بن جرير الطبري (ت٣١٠هـ)، نشر مؤسسة الأعلمي، بيروت، ١٣٥٨هـ، ١٩٣٩م.
٣٠٨ -المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي (ت٥٩٧هـ)، طبع ونشر دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا.
٣٠٩ -منهاج الكرامة في معرفة الإمامة: العلاّمة الحلّي (ت٧٢٦هـ)، الطبعة الأولى ١٣٧٩ش، مطبعة الهادي، قم المقدّسة، نشر انتشارات تاسوعاء، مشهد، تحقيق الأستاذ عبد الرحيم مبارك.
٣١٠ -موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: علي بن أبي بكر الهيثمي (ت٨٠٧هـ)، الطبعة الأولى ١٤١١هـ/١٩٩٠م، نشر دار الثقافة العربية، بيروت، دمشق، تحقيق حسين سليم أسد الداراني.
٣١١ -موضح أوهام الجمع والتفريق: أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت٤٦٣هـ)، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ، نشر دار المعرفة، بيروت، تحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجي.
٣١٢ -موطأ مالك: مالك بن أنس (ت١٧٩هـ)، طبع ١٤٠٦هـ/١٩٨٥م، دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
٣١٣ -الموفقيات: الزبير بن بكار، مطبعة العاني، بغداد ١٩٧٢م، تقديم د. صالح أحمد العلي، تحقيق د. سامي مكي العاني.
٣١٤ -ميزان الاعتدال في نقد الرجال: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت٧٤٨هـ)، الطبعة الأولى ١٣٨٢هـ/١٩٦٣م، نشر دار المعرفة، بيروت،
تحقيق علي محمد البجاوي.
٣١٥ -نثر الدر: أبو سعد منصور بن الحسين الآبي، نشر دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، تحقيق خالد عبد الغني محفوظ.
٣١٦ -النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: جمال الدين يوسف بن تغري بردي الأتابكي (ت٨٧٤هـ)، الطبعة الثانية ١٣٤٨هـ/١٩٢٩م، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة، مصر.
٣١٧ -النصائح الكافية لمَنْ يتولّى معاوية: محمد بن عقيل العلوي (ت١٣٥٠هـ)، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ، طبع ونشر دار الثقافة، قم المقدّسة.
٣١٨ -نصب الراية: أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي (ت٧٦٢هـ)، الطبعة الأولى ١٩٩٥م، مطابع الوفاء، المنصورة، نشر دار الحديث، القاهرة، مصر، تحقيق أيمن صالح شعبان.
٣١٩ -نظم درر السمطين: محمد بن يوسف الزرندي الحنفي (ت٧٥٠هـ)، الطبعة الأولى، ١٣٧٧ هـ/١٩٥٨ه.
٣٢٠ -نهاية الإرب في فنون الأدب: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري (ت٧٣٣هـ)، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ، طبع ونشر دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق مفيد حميقة وجماعة.
٣٢١ -النهاية في غريب الحديث: ابن الأثير (ت٦٠٦هـ)، الطبعة الرابعة ١٣٦٤ش، طبع ونشر مؤسسة إسماعيليان، قم، تحقيق طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي.
٣٢٢ -نهج الإيمان: علي بن يوسف بن جبر (ق٧)، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ، مطبعة ستاره، قم، تحقيق السيد أحمد الحسيني.
٣٢٣ -نهج البلاغة: الشريف الرضي (ت٤٠٤هـ)، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ، نشر دار المعرفة، بيروت، شرح الشيخ محمد عبده.
٣٢٤ -نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار: الشيخ مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجي من علماء القرن (١٣هـ)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ١٩٤٨م.
٣٢٥ -نيل الأوطار: محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت١٢٥٥هـ)، نشر دار الجيل، بيروت، لبنان، ١٩٧٣م.
٣٢٦ -الهداية الكبرى: أبو عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي (ت٣٣٤هـ)، الطبعة الرابعة ١٤١١هـ/١٩٩١م، طبع ونشر مؤسسة البلاغ، بيروت.
٣٢٧ -الهواتف: ابن أبي الدنيا عبد الله بن محمد القرشي (ت٢٨١هـ)، الطبعة الأولى ١٩٩٣م، طبع ونشر مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا.
٣٢٨ -الوافي: محمد بن المرتضى، المعروف بالفيض الكاشاني (ت١٠٩١هـ)، طبعة حجرية، مطبعة المكتبة الإسلامية بالأوفست.
٣٢٩ -الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت٧٦٤هـ)، الطبعة ٢٠٠٠م، نشر دار إحياء التراث بيروت، لبنان، تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى.
٣٣٠ -وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: محمد بن الحسن الحرّ العاملي (ت١١٠٤هـ)، الطبعة الخامسة ١٤٠٣هـ، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي.
٣٣١ -وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى: علي بن أحمد السمهودي (ت٩١١هـ)،
الطبعة الأولى ٢٠٠٦م، منشورات محمد علي بيضون، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق خالد عبد الغني محفوظ.
٣٣٢ -وفيات الأعيان وأنباء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان (ت٦٨١هـ)، نشر دار الثقافة، بيروت، تحقيق د. إحسان عباس.
٣٣٣ -وقعة صفين: نصر بن مزاحم المنقري (ت٢١٢هـ)، الطبعة الثانية ١٣٨٢هـ، مطبعة المدني، مصر، نشر المؤسسة العربية الحديثة، القاهرة، تحقيق عبد السلام محمد هارون.
٣٣٤ -اليقين باختصاص مولانا علي (عليه السّلام) بإمرة المؤمنين: رضي الدين علي بن موسى بن طاووس (٦٦٤هـ)، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ، مطبعة نمونه، نشر مؤسسة دار الكتاب (الجزائري)، تحقيق الأنصاري.
٣٣٥ -ينابيع المودّة لذوي القربى: الشيخ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي (ت١٢٩٤هـ)، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ، نشر دار الأسوة، تحقيق السيد علي جمال أشرف الحسيني.
المحتويات
المقدّمة ١٣
نظرية أنّ التخطيط لواقعة الطفّ بَشريّ ١٣
نظرية أنّ التخطيط للواقعة إلهي ١٤
تأكيد النصوص على أنّ التخطيط لفاجعة الطفّ إلهي ١٥
الشواهد المؤكّدة لكون التخطيط للفاجعة إلهي ١٦
إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت بالفاجعة قبل وقوعها ١٦
توقّع الناس للفاجعة قبل وقوعها ١٦
بعض التفاصيل المناسبة لانتهاء النهضة بالفاجعة ٢١
توقّع الإمام الحسين (عليه السّلام) أنّ عاقبة نهضته القتل ٢٢
الحثّ على نصر الإمام الحسين (عليه السّلام) والتأنيب على خذلانه ٢٥
الإمام الحسين (عليه السّلام) مأمور بنهضته عالم بمصيره ٢٦
الشواهد على أنّه (عليه السّلام) لم يتحرّ مظان السلامة ٢٨
إخبار الإمام الحسين (عليه السّلام) لمَنْ معه بخذلان الناس له ٣٠
تهيؤ الإمام الحسين (عليه السّلام) للقاء الحرّ وأصحابه ٣٠
اتفاقه (عليه السّلام) مع الحرّ في الطريق ٣٢
امتناعه (عليه السّلام) من الذهاب لجبل طيء ٣٣
تصريحه (عليه السّلام) حين وصوله كربلاء بما عُهد إليه ٣٤
تنبيهه (عليه السّلام) لظلامته وتمسّكه بموقفه ٣٥
الظروف التي أحاطت بالنهضة لا تناسب انتصاره عسكري ٣٧
ظهور الإحراج عليه (عليه السّلام) مع ناصحيه ٣٩
اعتذاره (عليه السّلام) برؤياه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنّه ماضٍ لما أمره ٤٠
إخباره (عليه السّلام) لأخيه بما أمره به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرؤيا ٤١
بعض شواهد إصراره (عليه السّلام) على الخروج للعراق مع علمه بمصيره ٤٢
رواية الفريقين للمضامين السابقة شاهد بصحته ٤٣
رواية الفريقين إخبار الأنبياء السابقين بالفاجعة ٤٣
كتابه (عليه السّلام) إلى بني هاشم بالفتح الذي يحقّقه ٤٦
إخبار الإمام السجّاد (عليه السّلام) بأنّ أباه (عليه السّلام) هو الغالب ٤٦
خلود الفاجعة يناسب أهميتها ٤٧
لا موجب لإطالة الكلام في تفاصيل النهضة الشريفة ٤٧
عظمة الإمام الحسين (عليه السّلام) وروح التضحية التي يحمله ٤٨
تحلّي الإمام الحسين (عليه السّلام) بالعاطفة ٤٩
الموقف المشرّف لِمَنْ في ركبه من عائلته وصحبه ٥١
المقصد الأوّل: في أبعاد فاجعة الطفّ وعمقها وردود الفعل المباشرة لها ٥٣
الفصل الأوّل: في أبعاد فاجعة الطفّ وعمقه ٥٣
تمهيد: ٥٣
استنكار جمهور المسلمين لعهد معاوية ليزيد ٥٣
كان الإمام الحسين (عليه السّلام) مسالماً في دعوته للإصلاح ٥٥
قتل الإمام الحسين (عليه السّلام) هو الجريمة الأولى ٥٨
الإمام الحسين (عليه السّلام) هو الرجل الأوّل في المسلمين ٦١
جريمة قتل أهل البيت (عليهم السّلام) الذين معه ٦٧
قتل الثلّة الصالحة من أصحاب الحسين (عليه السّلام) معه ٧٠
قتل الأطفال بما فيهم الرضيع ٧٣
التضييق على ركب الإمام الحسين (عليه السّلام) ومنعهم من الماء ٧٥
انتهاك حرمة العائلة النبويّة ٧٥
انتهاك حرمة الأجساد الشريفة بعد القتل ٧٦
النيل من الإمام الحسين (عليه السّلام) وأهل بيته ٧٦
الإمام الحسين (عليه السلام) بقية أصحاب الكساء ٧٨
تذكّر الناس أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره عن عظم الجريمة ٧٩
تشفّي الأمويين بالفاجعة ثأراً لأسلافهم المشركين ٧٩
الجو الديني الذي عاشه الإمام الحسين (عليه السّلام) وأصحابه ٨١
الأحداث الكاشفة عن ارتباط الفاجعة بالله تعالى ٨٣
الرؤى المؤكّدة لعظم الجريمة ٨٩
نوح الجنّ على الإمام الحسين (عليه السّلام) ٩١
التنكيل الإلهي بقتلته (عليه السّلام) وما حصل فيما سلب منه ٩٢
الإمام الحسين (عليه السّلام) ثار الله تعالى وابن ثاره ٩٢
الفصل الثاني: في ردود الفعل المباشرة لفاجعة الطف ٩٥
المقام الأوّل: في رد الفعل من قبل الناس ٩٥
إنكار بعض الصحابة على يزيد وابن زياد ٩٧
إنكار يحيى بن الحكم ٩٨
إنكار ابن عفيف الأزدي على ابن زياد في مسجد الكوفة ٩٩
إنكار امرأة من آل بكر بن وائل ١٠٠
موقف جمهور أهل الكوفة ١٠١
موقف جمهور أهل المدينة المنوّرة ١٠٣
موقف أهل المدينة عند رجوع العائلة الثاكلة إليه ١٠٥
موقف الناس في الشام ١٠٦
وقع الحدث في أمصار المسلمين البعيدة ١٠٦
محاولة الإمام الحسين (عليه السّلام) نشر مناقب أهل البيت (عليهم السّلام) ١٠٧
جهود العائلة الثاكلة في كشف الحقيقة وتهييج العواطف ١٠٨
فاجعة الطفّ أشدّ جرائم يزيد وقعاً في نفوس المسلمين ١١٢
ندم جماعة من المشاركين في المعركة ١١٢
ندم عمر بن سعد وموقف الناس منه ١١٢
ندم جماعة لتركهم نصرة الإمام الحسين (عليه السّلام) ١١٤
استغلال المعارضة للفاجعة ضدّ الحكم الأموي ١١٥
المقام الثاني: في موقف السلطة نتيجة ردّ الفعل المذكور وانقلاب موقفها من الحدث ومن عائلة الإمام الحسين (صلوات الله عليه) ١١٧
شواهد أمر يزيد بقتل الإمام الحسين (عليه السّلام) ١١٨
محاولة يزيد التنصّل من الجريمة واستنكاره لها ١٢٧
محاولة ابن زياد التنصّل من الجريمة وشعوره بالخطأ ١٢٩
موقف الحكّام إذا أدركوا سوء عاقبة جرائمهم عليهم ١٣١
موقف معاوية ممّا فعله بسر بن أرطاة ١٣١
موقف عبد الملك بن مروان من الفاجعة ١٣٣
إدراك الوليد بن عتبة سوء أثر الجريمة على الأمويين ١٣٤
موقف معاوية المسبق من الجريمة ١٣٥
المقصد الثاني: في ثمرات فاجعة الطفّ وفوائدها ١٣٧
الفصل الأوّل: فيما جناه الدين من ثمرات فاجعة الطفّ ١٣٧
الهدف الأوّل للإمام الحسين (عليه السّلام) ١٣٧
الزيارات المتضمّنة أنّ الهدف إيضاح معالم الدين ١٤٢
أهمية بقاء معالم الدين ووضوح حجّته ١٤٤
تميّز الإسلام بما أوجب إيضاح معالمه وبقاء حجّته ١٤٤
ما يتوقّف عليه بقاء معالم الدين الحق ووضوح حجّته ١٤٥
المطلب الأوّل: فيما كسبه الإسلام بكيانه العام ١٤٧
تمهيد: ١٤٧
يجب بقاء الدين الحق واضح المعالم ظاهر الحجّة ١٤٧
لا بدّ من رعاية المعصوم للدين ١٤٨
استغلال السلطة المنحرفة الدعوة ومبادئها لصالحها ١٥٠
غلبة الباطل لا توجب ضياع الدين الحقّ وخفاء حجّته ١٥١
لا ملزم بوضوح معالم الدين بعد نسخه ١٥٣
كون الإسلام خاتم الأديان يستلزم بقاء معالمه ووضوح حجّته ١٥٣
المبحث الأوّل: فيما من شأنه أن يترتّب على انحراف مسار ١٥٥
السلطة في الإسلام لو لم يكبح جماحها ١٥٥
وجوب معرفة الإمام والإذعان بإمامته ١٥٦
وجوب طاعة الإمام وموالاته والنصيحة له ١٥٧
لزوم جماعة المسلمين والمؤمنين وحرمة التفرّق ١٥٨
أهمية هذه الأمور في نظم أمر الدين والمسلمين ١٥٩
طاعة الإمام المعصوم مأمونة العاقبة على الدين والمسلمين ١٦٠
طاعة الإمام ولزوم جماعته مدعاة للطفّ الإلهي ١٦٠
انحراف مسار السلطة في الإسلام ١٦١
إنكار أمير المؤمنين والزهراء (عليهما السّلام) لِما حصل ١٦١
اضطرار أمير المؤمنين (عليه السّلام) للمسالمة ١٦٢
أثر الفتوح في تركز الإسلام واحترام رموز السلطة ١٦٢
غياب الإسلام الحقّ ورموزه عن ذاكرة المسلمين ١٦٣
دعم أمير المؤمنين (عليه السّلام) السلطة اهتماماً بكيان الإسلام ١٦٣
تقييم أمير المؤمنين (عليه السّلام) للأوضاع ١٦٦
استغلال الألقاب المناسبة لشرعية السلطة ونقلها عن أهلها ١٦٧
عدم شرعية استغلال السلطة لهذه الألقاب ١٧١
اختصاص لقب أمير المؤمنين بالإمام علي (عليه السّلام) ١٧٢
تحجير السلطة على السُنّة النبويّة ١٧٤
قسوة السلطة في تنفيذ مشروعها ١٧٥
سيرة عمر أيّام ولايته ١٧٧
وضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصالح السلطة ١٨١
كلام أمير المؤمنين (عليه السّلام) في أسباب اختلاف الحديث ١٨٢
شكوى أمير المؤمنين (عليه السّلام) من التحريف وتعريضه بالمحرّفين ١٨٤
تأكيد السلطة على أهميّة الإمامة وعلى الطاعة ولزوم الجماعة ١٨٦
تبدّل موقف العباسيين من خلافة الأمويين ٢٠٨
أثر هذه الثقافة على العامّة ٢٠٩
أثر هذه الثقافة في إفريقية ٢٠٩
موقف عبد الله بن عمر من الإمامة والجماعة ٢١١
الأحاديث والفتاوى في دعم هذا الاتجاه ٢١٣
مشابهة الاتجاه المذكور للتعاليم المسيحية الحالية ٢١٤
حديث أمير المؤمنين (عليه السّلام) في حقوق الوالي والرعية ٢١٤
ما تقتضيه القاعدة في البيعة ٢١٥
ما آل إليه أمر وجوب البيعة والطاعة ولزوم الجماعة ٢١٦
اختلاف الأُمّة في الحقّ خير من اتفاقها على الباطل ٢١٧
استعانة السلطة بالمنافقين وحديثي الإسلام ٢١٧
السلطة تمكّن للأمويين وخصوصاً معاوية ٢١٨
ظهور الاستهتار من المنافقين ٢٢٠
موقف أُبي بن كعب وموته ٢٢٤
تبرير السلطة بعض مواقفها بالقضاء والقدر ٢٢٦
قيام كيان الإسلام العام على الطاعة العمياء للسلطة ٢٢٨
تعرّض الدين للتحريف ٢٢٩
جهل المتصدّين للفتوى والقضاء ٢٢٩
ظهور الاختلاف في الحديث والقضاء والفتوى ٢٣٠
كلام أمير المؤمنين (عليه السّلام) حول اختلاف القضاء ٢٣١
ظهور الجرأة على الفتوى والقضاء ٢٣٢
شكوى أمير المؤمنين (عليه السّلام) من أوضاع الأُمّة ٢٣٢
ظهور الابتداع في الدين ومخالفة نصوصه ٢٣٣
تشويه الحقائق في التاريخ والمناقب والمثالب ٢٣٤
ظهور حجم الخطر بملاحظة ثقافة الأمويين ٢٣٤
نماذج من التحريف في العهد الأموي ٢٣٤
المبحث الثاني: في جهود أهل البيت عليهم السلام في كبح جماح الانحراف وما كسبه الإسلام بكيانه العام من ذلك ٢٥٣
المقام الأوّل: في جهود أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) وجهود الخاصّة من الصحابة والتابعين الذين كانوا معه ٢٥٤
تخوّف عمر بن الخطاب من أطماع قريش ٢٥٥
تحجير عمر على كبار الصحابة ٢٥٥
توقّف أهل البيت (عليهم السّلام) عن تنبيه عامّة المسلمين لحقّهم في الخلافة ٢٥٨
إحساس عمر بأنّ الاستقرار على وشك النهاية ٢٥٨
تنبؤ الصديقة الزهراء (عليها السّلام) باضطراب أوضاع المسلمين ٢٥٩
مجمل الأوضاع في أوائل عهد عثمان ٢٥٩
غفلة العامّة عن ابتناء بيعة عثمان على الانحراف ٢٦٠
مدى اندفاع العامّة مع السلطة في تلك الفترة ٢٦٢
اختلاف عثمان عن عمر في الحزم والسلوك ٢٦٤
ظهور الإنكار على عثمان من عامّة المسلمين ٢٦٤
تحقّق الجو المناسب لإظهار مقام أمير المؤمنين (عليه السّلام) وبيان ظلامته ٢٦٥
جهود الخاصة في التعريف بمقامه (عليه السّلام) وكشف الحقيقة ٢٦٥
توجّهات المعارضة لعثمان ٢٦٧
مقتل عثمان بعد فشل مساعي أمير المؤمنين (عليه السّلام) لحلّ الأزمة ٢٦٧
مطالبة الجماهير ببيعة أمير المؤمنين (عليه السّلام) ٢٦٨
إباء أمير المؤمنين (عليه السّلام) البيعة تنبئه بالمستقبل القاتم ٢٦٩
بيعة أمير المؤمنين (عليه السّلام) وما استتبعها من تداعيات ٢٧٠
قد يبدو فشل أمير المؤمنين (عليه السّلام) في تسلّمه للسلطة ٢٧٠
علمه (عليه السّلام) بفشل مشروع الإصلاح الجذري ٢٧٠
أهداف أمير المؤمنين (عليه السّلام) من تسلّمه للسلطة ٢٧٣
سعيه (عليه السّلام) لإيضاح الحقائق الدينية ٢٧٣
إصحاره (عليه السّلام) بالحقيقة وبحقّه في الخلافة وبظلامته ٢٧٤
إيضاحه للمراد من الجماعة التي يجب لزومها ٢٧٥
مميّزاته الشخصية ساعدت على تأثيره وسماع دعوته ٢٧٧
إيمان ثلّة من الخاصّة بدعوته (عليه السّلام) وتضحيتهم في سبيلها ٢٧٨
العقبة الكؤود في طريق الدعوة احترام الأوّلين ٢٧٩
خطبة له (عليه السّلام) يستعرض فيها كثيراً من البدع ٢٨٠
إيضاحه (عليه السّلام) لأحكام حرب أهل القبلة ٣٠٣
سيرته (عليه السّلام) في حروبه صارت سنّة للمسلمين ٣٠٤
إسلام الباغي يعصمه من الرق ويعصم ماله ٣٠٥
سقوط حرمة الباغي وانقطاع العصمة معه ٣٠٧
الخلاصة في هدفه (عليه السّلام) من تولي السلطة ٣٠٩
قيامه (عليه السّلام) بالأمر بعد عثمان بعهد من الله تعالى ٣١٠
كلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة ٣١٠
المقام الثاني: في مواجهة السلطة لجهود أمير المؤمنين (عليه السّلام) وخاصته ٣١٣
اهتمام معاوية بالقضاء على خط أهل البيت (عليهم السّلام) ٣١٣
إدراك معاوية قوة خط أهل البيت (عليهم السّلام) عقائدي ٣١٤
دعم العقل والدليل لخط أهل البيت (عليهم السّلام) ٣١٤
انشداد الناس عاطفياً لخط أهل البيت (عليهم السّلام) ٣١٧
ظهور فشل نظرية عدم النص في الخلافة ٣١٧
تنبؤ سيدة النساء فاطمة (عليه السّلام) وغيرها بنتائج الانحراف ٣١٨
انتشار التشيع إذا لم تزرع الألغام في طريقه ٣١٩
الألغام التي زرعها معاوية في طريق التشيع ٣١٩
التنكيل بالشيعة ٣٢٠
أثر التنكيل بالشيعة على التشيع ٣٢٠
عود التحجير على السنة النبوية ٣٢٠
المنع من رواية الأحاديث المؤيدة لخط أهل البيت (عليهم السّلام) ٣٢١
محاورة معاوية مع ابن عباس ٣٢٢
افتراء الأحاديث القادحة في أهل البيت (عليهم السّلام) ٣٢٣
موقف الجمهور من الأحاديث المذكورة ٣٢٤
افتراء الأحاديث في فضل الصحابة والخلفاء الأولين ٣٢٥
تقديس الأوّلين يقف حاجزاً دون تقبّل النصّ ٣٢٩
ضعف غلواء تقديس الشيخين في أواخر العهد الأموي ٣٣٠
مهاجمة العباسيين للأوّلين في بدء الدعوة ٣٣١
تراجع المنصور وتقديمه للشيخين ٣٣٣
اعتراف المنصور ومَنْ بعده بشرعية خلافة الأمويين ٣٣٣
تراجع المأمون عن موقف آبائه ٣٣٦
تأكّد عدالة الصحابة وتقديس الشيخين في عهد المتوكّل ٣٣٧
قوّة خطّ الخلافة عند الجمهور يفضي إلى تحكيم السلطة في الدين ٣٤١
تفاقم الخطر بتحويل الخلافة إلى قيصرية أموية ٣٤٦
حديث المغيرة بن شعبة عن خطر البيعة ليزيد ٣٤٦
ما حصل هو النتيجة الطبيعية لخروج السلطة عن موضعها ٣٤٧
المقام الثالث: في أثر فاجعة الطفّ في الإسلام بكيانه العام ٣٤٩
أحكم معاوية بناء دولة قوية ٣٤٩
امتعاض ذوي الدين من انحراف السلطة عن تعاليمه ٣٥٠
مَنْ يرى إمكان إصلاح السلطة وتعديل مسارها ٣٥١
مَنْ يرى تجنّب الاحتكاك بالسلطة حفاظاً على الموجود ٣٥١
موقف أهل البيت (عليهم السّلام) إزاء المشكلة ٣٥٤
بيعة يزيد تعرض جهود أمير المؤمنين (عليه السّلام) للخطر ٣٥٤
عدم تبلور مفهوم التقيّة ٣٥٥
لم يخرج على سلطة الأمويين إلّا الخوارج الذين سقط اعتبارهم ٣٥٧
موقف الشيعة من الأوّلين يحول دون تفاعل الجمهور معهم ٣٥٨
التفاف السلطة على الخاصة لإضعاف تأثيرهم على الجمهور ٣٥٩
شرعية السلطة تيسّر لها التدرّج في تحريف الدين ٣٦٠
تبعية الدين للسلطة تخفف وقعه في نفوسهم ٣٦١
قد ينتهي التحريف بتحول الدين إلى أساطير وخرافات ٣٦١
ضرورة إحراج السلطة بموقف يلجئها لمغامرة سابقة لأوانها ٣٦٢
سنوح الفرصة لاتخاذ الموقف المذكور بعد معاوية ٣٦٣
اقتحام السلطة له (عليه السّلام) يزيدها جرأة على انتهاك الحرمات ٣٦٤
استهتار السلطة بعد سقوط شرعيتها لا يضرّ بالدين ٣٦٥
أثر الفاجعة في حدّة الخلاف بين الشيعة وخصومهم ٣٦٥
دفع محاذير الاختلاف ٣٦٦
مواقف الأنبياء والأوصياء وجميع المصلحين ٣٦٦
المقارنة بين دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفاجعة الطفّ ٣٦٧
لا بدّ من حصول الخلاف بين المسلمين بسبب الانحراف ٣٦٧
محذور إضعاف الدولة العربية والإسلامية ٣٦٨
الدولة بتركيبتها معرّضة للضعف والانهيار ٣٦٨
لا أهمية للدولة العربية في منظور الإسلام ٣٦٩
لو شكر العرب النعمة ٣٧٠
إظهار دعوة الإسلام الحقّ أهم من قوّة دولته ٣٧١
حقّقت فاجعة الطفّ هدفها على الوجه الأكمل ٣٧٢
تداعيات فاجعة الطفّ في المراحل اللاحقة ٣٧٣
ثورة أهل المدينة وعبد الله بن الزبير ٣٧٣
موت يزيد بن معاوية ٣٧٤
إعلان معاوية بن يزيد عن جرائم جدّه وأبيه ٣٧٤
انتقام الأمويين من مؤدّب معاوية بن يزيد ٣٧٧
انهيار دولة آل أبي سفيان ٣٧٨
اختلاف الأمويين وتعدد الاتجاهات في العالم الإسلامي ٣٧٨
تنبؤ الصديقة فاطمة (عليها السّلام) بما آلت إليه الأمور ٣٧٨
أهمية الفترة الانتقالية التي استمرت عشر سنين ٣٧٩
وضوح عزل الدين في الصراع على السلطة وفي كيانها ٣٧٩
اتضاح أنّ بيعة الخليفة لا تقتضي شرعية خلافته ٣٨١
اتضاح أنّ وجوب الطاعة ولزوم الجماعة لا يعني الانصياع للسلطة ٣٨٢
تخبّط الجمهور في تحديد وجوب الطاعة ولزوم الجماعة ٣٨٣
تناسق مفهوم الإمامة والطاعة والجماعة عند الإمامية ٣٨٤
الخروج على السلطة لم يَعُدْ يختصّ بالخوارج ٣٨٥
صارت الإمامة عند الجمهور دنيوية لا دينية ٣٨٦
كسر طوق الضغط الثقافي في الفترة الانتقالية ٣٨٨
مكسب التشيّع نتيجة كسر طوق الضغط الثقافي ٣٨٨
التوجّه الديني في المجتمع الإسلامي نتيجة فاجعة الطفّ ٣٨٩
حاجة المجتمع الإسلامي لمتخصصين في الثقافة الدينية ٣٩١
أهمية دور رجال الشيعة في مجال التخصص الديني ٣٩٢
عدم اقتصار الأمر على الشيعة ٣٩٣
ظهور طبقة الفقهاء والمحدّثين ٣٩٣
الاتفاق على انحصار مرجعية الدين بالكتاب والسُنّة ٣٩٣
تعامل السلطة مع الواقع الجديد بتنسيق وحذر ٣٩٤
إقدام السلطة على تدوين السُنّة ٣٩٤
تبنّي الخلفاء لبعض الفقهاء لكسب الشرعية منهم ٣٩٥
مكسب الدين نتيجة هذين الأمرين ٣٩٥
موقف مالك بن أنس صاحب المذهب ٣٩٦
قوّة الكيان الشيعي نتيجة ما سبق ٣٩٧
تحوّل مسار الثقافة الدينية بعد الفترة الانتقالية ٣٩٨
عقدة احترام سُنّة الشيخين ٣٩٨
موقف عمر بن عبد العزيز ٤٠١
التغلّب أخيراً على عقدة سيرة الشيخين ٤٠٢
موقف الجمهور أخيراً من سُنّة الشيخين ٤٠٣
المطلب الثاني: فيما كسبه التشيّع لأهل البيت (عليهم السّلام) بخصوصيته ٤٠٥
المقام الأوّل: في مكسب التشيّع من حيثية الاستدلال ٤٠٧
اعتماد التشيّع بالدرجة الأولى على الكتاب والسُنّة ٤٠٧
انحصار المرجعية في الدين بالكتاب والسُنّة انتصار للتشيّع ٤٠٨
الطرق الملتوية التي سلكها خصوم التشيّع لتضييع هذا الانتصار ٤٠٨
رفض الإمام الحسين (عليه السّلام) نظام الجمهور في الخلافة ٤١٠
المقام الثاني: في الجانب العاطفي ٤١٢
نهضة الإمام الحسين (عليه السّلام) شيعية الاتجاه ٤١٢
فوز التشيّع بشرف التضحية في أعظم ملحمة دينية ٤١٦
نقمة الظالمين على الشيعة في إحياء فاجعة الطفّ ٤١٧
فاجعة الطفّ زعزعت شرعية نظام الخلافة عند الجمهور ٤١٨
فاجعة الطفّ هي العقبة الكؤود أمام نظام الخلافة ٤١٨
موقف بعض علماء الجمهور من إحياء الفاجعة ٤١٩
كلام الغزالي ٤١٩
كلام التفتازاني ٤٢٠
كلام الربيع بن نافع الحلبي حول معاوية ٤٢١
موقف الغلاة لم يمنع الشيعة من ذكر كرامات أهل البيت (عليهم السّلام) ٤٢٢
محاولة كثير من الجمهور الدفاع للظالمين ٤٢٢
الدفاع عن الظالمين يصبّ في صالح التشيّع ٤٢٣
المقام الثالث: في الإعلام والإعلان عن دعوة التشيّع ونشر ثقافته ٤٢٥
اهتمام الشيعة بإحياء الفاجعة وجميع مناسبات أهل البيت (عليهم السّلام) ٤٢٥
منع الظالمين من إحياء مناسبات أهل البيت (عليهم السّلام) ٤٢٦
أثر المنع المذكور على موقف الشيعة ٤٢٦
أثر إحياء المناسبات المذكورة في حيوية الشيعة ونشاطهم ٤٢٧
أثر هذا الإحياء في جمع شمل الشيعة وتقوية روابطهم ٤٢٧
أثر الإحياء المذكور في تثبيت هوية الشيعة ٤٢٨
نشر الثقافة العامّة والدينية بسبب الإحياء المذكور ٤٢٨
تأثير إحياء تلك المناسبات في إصلاح الشيعة نسبياً ٤٢٩
إيصال مفاهيم التشيّع بإحياء تلك المناسبات ٤٣٠
خلود دعوة التشيّع بإحياء هذه المناسبات ٤٣١
فاجعة الطفّ نقطة تحول مهمة في صالح التشيّع ٤٣٢
الفصل الثاني: في العبر التي تستخلص من فاجعة الطفّ ٤٣٥
المقام الأوّل: في آليّة العمل ٤٣٥
سلامة آليّة العمل وشرفه ٤٣٥
على مدّعي الإصلاح التزام سلامة آليّة العمل ٤٣٩
لا يتابع مدّعي الإصلاح مع عدم سلامة آليّة العمل ٤٤٠
المقام الثاني: في النتائج ٤٤٢
كشفت فاجعة الطفّ عن تعذّر إصلاح المجتمع بالوجه الكامل ٤٤٣
لا ينبغي الاغترار باندفاعات الناس العاطفية ٤٤٥
ينحصر الأمر بمحاولة الإصلاح النسبي ٤٤٥
مسألة الأئمة المتأخرين عليهم السلام للسلطة ٤٤٦
حديث سدير الصيرفي ٤٤٨
دعوى أنّ ذلك لا يتناسب مع قابلية الإسلام للتطبيق ٤٥٠
دفع الدعوى المذكورة ٤٥٠
صلاح المجتمع مدعاة للتسديد والفيض الإلهي ٤٥٢
إنّما يتعذّر الإصلاح الكامل بعد حصول الانحراف ٤٥٤
زيادة الأمر تعقّداً في عصر الغيبة ٤٥٤
لا يسقط الميسور من الإصلاح بالمعسور ٤٥٥
المقصد الثالث: في توقيت فاجعة الطفّ ٤٥٧
الفصل الأوّل: في موقف أمير المؤمنين (عليه السّلام) ٤٥٩
اهتمام أمير المؤمنين (عليه السّلام) بحفظ كيان الإسلام العام ٤٥٩
اهتمامه (عليه السّلام) بالحفاظ على حياته وحياة الثلّة الصالحة ٤٦٠
الصراع الحاد بين الصدر الأوّل يعرّض الكيان الإسلامي للانهيار ٤٦١
قوّة الكيان الإسلامي العام في عصر الإمام الحسين (عليه السّلام) ٤٦١
الصراع الحاد يعرّض الخاصة للخطر ٤٦٢
تركّز دعوة التشيّع في عصر الإمام الحسين (عليه السّلام) ٤٦٢
حاول أمير المؤمنين (عليه السّلام) تعديل مسار السلطة لكنّه فقد الناصر ٤٦٣
دعوى أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) فرّط ولم يستبق الأحداث ٤٦٣
الجواب عن الدعوى المذكورة ٤٦٤
حديث لأمير المؤمنين (عليه السّلام) في تقييم الأوضاع ٤٦٦
الفصل الثاني: في موقف الإمام الحسن (عليه السّلام) ٤٦٩
المقام الأوّل: في صلح الإمام الحسن (عليه السّلام) مع معاوية ٤٧٠
تعذّر انتصار الإمام الحسن (عليه السّلام) عسكرياً ٤٧٠
خطبة الإمام الحسن (عليه السّلام) ٤٧١
مخاطر الانكسار العسكري على دعوة الحقّ وحملتها ٤٧٢
تصريحات الإمام الحسن وبقيّة الأئمّة (عليهم السّلام) في توجيه الصلح ٤٧٥
لا مجال لاستمرار الإمام (عليه السّلام) في الحرب حتى النفس الأخير ٤٧٩
تأييد الإمام الحسين (عليه السّلام) لموقف الإمام الحسن (عليه السّلام) ٤٨٢
عظمة الإمام الحسن (عليه السّلام) في موقفه ٤٨٢
المقام الثاني: في عدم مواجهة الإمام الحسن (عليه السّلام) لمعاوية بعد ظهور غدره ٤٨٤
تحرّك الشيعة في حياة الإمام الحسن (عليه السّلام) ٤٨٥
تقوية معاوية لسلطانه في فترة حكمه ٤٨٦
استغلال معاوية للعهد ٤٨٧
موقف الإمام الحسين (عليه السّلام) في عهد معاوية بعد أن تقلّد الإمامة ٤٩٠
الفصل الثالث: في موقف الأئمّة من ذرية الحسين (عليه السّلام) ٤٩٣
لا موجب للتضحية بعد فاجعة الطفّ ٤٩٣
اهتمام الأئمّة (عليهم السّلام) بالحفاظ على شيعتهم ٤٩٤
اهتمام الأئمّة (عليهم السّلام) بتقوية كيان الشيعة ٤٩٥
التأكيد على تعذّر تعديل مسار السلطة ولزوم مهادنتها ٤٩٥
ثمرات مهادنة السلطة ٤٩٥
التركيز على فاجعة الطفّ وعلى ظلامة أهل البيت (عليهم السّلام) ٤٩٦
التأكيد على زيارة الإمام الحسين (عليه السّلام) وجميع أهل البيت (عليهم السّلام) ٤٩٨
حديث معاوية بن وهب ٤٩٨
تحقيق الوعد الإلهي ببقاء قبره الشريف علماً للمؤمنين ٥٠٠
تجديد الذكرى بمرور السُنّة ٥٠١
شدّ الشيعة نحو الإمام الحسين (عليه السّلام) بمختلف الوجوه ٥٠٣
المدّ الإلهي والكرامات الباهرة ٥٠٤
الحكمة في التأكيد المذكور ٥٠٤
التأكيد على أهمّية الإمامة في الدين وبيان ضوابطها ٥٠٦
دعم مقام الإمامة بالكرامات والمعاجز ٥٠٦
اعتراف غير الشيعة بكرامات أهل البيت (عليهم السّلام) ٥٠٧
التأكيد على شدّة جريمة خصوم أهل البيت (عليهم السّلام) ٥٠٧
التركيز على الارتباط بالله تعالى بمختلف الوجوه ٥٠٧
التركيز على الأمور المذكورة في أحاديثهم (عليهم السّلام) ٥٠٨
التركيز على الأمور المتقدّمة في الأدعية والزيارات ٥٠٩
جامعية زيارة الجامعة الكبيرة وزيارة يوم الغدير ٥١٠
التأكيد على عدم شرعية الجور ٥١١
إحياء تعاليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته وجميع المعارف الحقة ٥١١
اهتمام الأئمّة (عليهم السّلام) بحملة آثارهم وعلماء شيعتهم ٥١٢
تأكيد الأئمّة (عليهم السّلام) على التفقّه في الدين وعلى إحياء أمرهم ٥١٣
قيام الحوزات العلمية الشيعية ومميّزاتها ٥١٤
تحديد الاجتهاد عند الشيعة ٥١٤
ظهور المرجعيات الدينية بضوابطها الشرعية ٥١٥
بعض الأحاديث في ضوابط التقليد ٥١٦
ارتباط الشيعة بمرجعياتهم الدينية عملياً وعاطفياً ٥١٦
قيادة المرجعية للأُمّة ٥١٧
العمق التاريخي للمرجعية ٥١٧
تأكيد الأئمّة (عليهم السّلام) على حقّهم في الخمس ٥١٨
استقلال التشيّع مادياً ٥١٩
استقلال الحوزات والمرجعية الدينية عن السلطة ٥١٩
تميّز الكيان الشيعي ٥٢٠
فرض الكيان الشيعي على أرض الواقع ٥٢١
تحقيق الوعد الإلهي ببقاء جماعة تلتزم الحقّ وتدعو له ٥٢١
تميّز دين الإسلام الحقّ ببقاء دعوته وظهور حجّته ٥٢٣
المقارنة بين فترة ما بين المسيح والإسلام ومدّة الغيبة ٥٢٣
الخاتمة ٥٢٧
الفصل الأوّل: في أثر وضوح معالم الإسلام في استقامة منهج الفكر الإنساني ٥٢٧
دافعت ثقافة الإسلام الحقّ عن الأديان السابقة ونبهت لتحريفه ٥٢٨
تنزيه رموز تلك الأديان عمّا نسبته لهم يد التحريف ٥٢٨
تحريف الأديان بنحو مهين ٥٣٠
لو تمّ تحريف الإسلام لضاعت معالم الحقّ على البشرية ٥٣٠
ظهور السلبيات التي أفرزها التحريف ٥٣١
الفصل الثاني: في إحياء فاجعة الطفّ ٥٣٥
اختلاف الناس في مظاهر التعبير عن شعورهم إزاء الأحداث ٥٣٥
أهمية السواد الأعظم في حمل الدعوة والحفاظ عليها ٥٣٦
موقع الخاصة من الدعوة ٥٣٦
أهمية فعاليات الجمهور في إحياء المناسبات الدينية ٥٣٧
على الخاصة دعم الجمهور في إحياء المناسبات بطريقتهم ٥٣٨
أهمّية الممارسات الصارخة ٥٣٩
الكلام في تطوير طرق إحياء المناسبات ٥٤٠
الوظيفة عند اختلاف وجهات النظر ٥٤٣
دعوى اختصاص أهمّية الإحياء بما إذا كان مقارعة للظلم ٥٤٤
دفع الدعوى المذكورة ٥٤٤
تأكيد رجحان إحياء المناسبات المذكورة في بعض الحالات ٥٤٨
في آداب إحياء المناسبات المذكورة ٥٤٨
لا تكن هذه المناسبات مسرحاً للصراعات ٥٥٠
أهمّية الجهد الفردي مهما تيسّر ٥٥١
حديث مسمع كردين ٥٥٢
ثبوت الأجر العظيم على إحياء أمرهم (عليهم السّلام) ٥٥٣
شبهة أنّ ذلك يشجع على المعصية ٥٥٤
دفع الشبهة المذكورة ٥٥٤
لا محذور في التركيز على نصوص الأجر والثواب ٥٥٦
رجحان الوعظ والتذكير باهتمام أهل البيت (عليهم السّلام) بالالتزام الديني ٥٥٧
حديث يزيد بن خليفة ٥٥٨
ملحق رقم (١) خطبة الزهراء (عليه السّلام) الكبرى ٥٦١
مصادر الخطبة ٥٧٤
ملحق رقم (٢) خطبة الزهراء (عليها السّلام) الصغرى ٥٨١
مصادر الخطبة ٥٨٦
ملحق رقم (٣) خطبة السيّدة زينب (عليها السّلام) في الكوفة ٥٨٩
مصادر الخطبة ٥٩٢
ملحق رقم (٤) خطبة السيّدة زينب (عليها السّلام) في مجلس يزيد في الشام ٥٩٥
مصادر الخطبة ٦٠٠
ملحق رقم (٥) خطبة الإمام زين العابدين (عليه السّلام) ٦٠١
مصادر الخطبة ٦٠٥
ملحق رقم (٦) حديث زائدة ٦٠٧
المصادر والمراجع ٦١٤