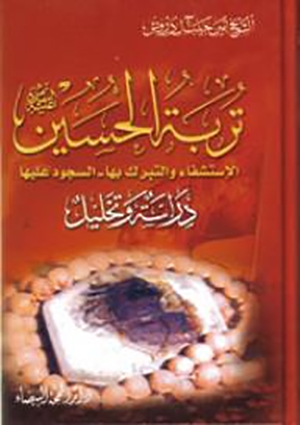تربة الحسين عليه السلام الجزء الثاني
الشيخ أمين حبيب آل درويش
دار المحجّة البيضاء
تربة الحسين عليه السلام الجزء الثاني
الشيخ أمين حبيب آل درويش
دار المحجّة البيضاء
مقدمة البحث
ـ الموضوع ودوافع إختياره
ـ أهميته
ـ تساؤلات البحث
ـ منهج وأسلوب البحث
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ، وبعد.
الموضوع ودوافع إختياره :
لقد حظيت الأرض التي قتل عليها سيد الشهداء عليه السلام بأنواع الشرف والمجد والقداسة ، بل أصبحت من أفضل بقاع الأرض ، وذلك منذ اليوم الذي حَلّ فيها ركب الحسين عليه السلام ، وأهل بيته وصحبه ، وأضحوا ضحايا للدين والعقيدة ، فتحولت إلى بقعة تضم تلك الأجساد الطاهرة ، وغدت بذلم محجة للقلوب ، تهوي إليها الألوف من كل مكان ، يلوذون بتلك الأضرحة تأكيداً للمحبة والمودة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وتخليداً لذكراه التي أظهرت معالم الدين والعقيدة ، ولما في ذلك من القرب إلى الباري عَزّ وجَلّ وتعظيماً لشعائره ، وخير شاهد على ذلك ما ذكرته الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار عليهم السلام ، من فضل لهذه التربة الطاهرة وعناية لشأنها ، من ولادة الحسين عليه السلام إلى شهادته ، حيث عرفت بتسميات كثيرة.
يقول الدكتور عبد الجواد الكليدار : «وقد نعتت كربلاء منذ الصدر الأول في كل من التاريخ والحديث باسم كربلاء ، والغاضرية ، ونينوى ، وعمورا ، وشاطئ الفرات ، وورد منها في الرواية والتاريخ باسم مارية
والنواويس ، والطف ، وطف الفرات ، ومشهد الحسين ، والحائر والحير ، إلى غير ذلك من الأسماء المختلفة الكثيرة ، إلا أنّ أهم هذه الأسماء في الدين هو الحائر ، لما أحيط بهذا الاسم من الحرمة والتقديس ، أو أنيط به من أعمال وأحكام في الرواية والفقه إلى يومنا هذا»(١) .
وقال أيضاً : «ولأرض كربلاء أسماء كثيرة ، المشهورة منها في كتب الأخبار والآثار ستة عشر اسماً وهي : كربلاء ، ونينوى ، الغاضرية ، شاطئ الفرات ، الطف ، قبة الإسلام ، عموراء ، مارية ، مكاناً قصياً»(٢) .
وبعد هذا نقول : إنّ كربلاء أم لقرى عديدة تقع بين بادية الشام وشاطئ الفرات ، ويحدثنا التاريخ أنها كانت من أمهات مدن بين النهرين ، الواقعة على ضفاف نهر بالاكوباس ـ الفرات القديم ـ ، وعلى أرضها معبد للعبادة والصلاة ، كما يستدل بذلك من الأسماء التي عرفت بها قديماً ، وقد أخذت كربلاء تزدهر شيئاً فشيئاً ، سيما على عهد الكلدانيين والتنوخيين واللخميين والمناذرة ، يوم كانت الحيرة عاصمتهم إلى عهد الفتح الإسلامي للعراق ، حينما توجه خالد بن عُرفُطَة بأمر من القائد العام سعد بن أبي وقاص إلى فتح كربلاء ، وبعد فتحها توجه خالد إلى فتح الحيرة ، وبعد فتحها عام ١٤ هـ عاد إلى كربلاء واتخذها مقراً لجنده ، ومعسكراً لجيشه مدة من الزمن ، وما كانت كربلاء هي أم لعدة قرى تحيط بها ؛ فقد أطلقت تلك الأسماء مجازاً على كربلاء ، ومن الملاحظ أن بعض أسماء هذه القرى عامة واسعة ، وبعضها خاصة لمنطقة ضيقة. وهذا هو موضوع البحث. ولعلّ من أهم الدوافع التي دفعتني لإختيار هذا الموضوع هي التالي :
__________________
(١) ـ الكليدار ، عبد الجواد : تأريخ كربلاء / ٢٣.
(٢) ـ الكليدار ، عبد الجواد : جغرافية كربلاء القديمة وبقاعها / ٤١ (مخطوط).
١ ـ ما ذكرته الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله الكرام ، من ربط مصرع الحسين عليه السلام وثواب زيارته بذكر اسم من أسماء أرض شهادته ، وما ترتب على ذلك من تعداد أسمائها ، وهذا يدل على الإهتمام بهذه البقعة الطاهرة.
٢ ـ إن الشباب المثقف حينما يقرأ هذه الروايات ، يقف مبهوراً أمام عظمة هذه البقعة الطاهرة ، وما يلاحظ من الأسماء الكثيرة التي أطلقت عليها ، ويتساءل عن مغزى ذلك ؛ لذا رأيت أن أقوم ببذل الجهود لتتبع هذه الأسماء وإستخراجها من الروايات ودراستها ، آملاً التوفيق للوصول إلى بعض أهداف ذلك.
أهميته :
إنّ البحث والدراسة في تربة الحسين عليه السلام غني بالفوائد ، ولا يتصور البعض أنّ البحث خاص بالتربة من حيث هي ، إذ التراب لا قيمة له من الناحية القدسية من حيث هو ، إنما القيمة تظهر بما يضاف إليه من أمور تجعله مقدّساً لدى العقلاء ، وإلا فهذه الأرض التي قتل فيها سيد الشهداء لم يكن لها فضل ومزية على غيرها من الأراضي ، إلا أنّه شاءت الأقدار أن يساق إليها ركب الحسين عليه السلام ، فارتبط تاريخها بتاريخ سيد الشهداء بل بتاريخ الإسلام ، بل من حقه أن يقترن بتاريخ البشرية جمعاء ، فالقدر الحكيم يرتفع بالتضحية في كربلاء إلى أعلى مستوياتها المرموقة ، نعم لقد أبرزت بطولات كربلاء شرف التضحية على نحو باهر وجليل ، حتى لنكاد نحسب أنّ الأقدار إنما أدت ذلك اليوم بكل أهواله وتضحياته ، لتؤكد شرف التضحية في وعي البشرية كلها ، ولتفيئ بمغزاه العظيم ضمير الحياة ، إذن هي شرف الإنسان وشرف الحياة ، فالناس بحاجة ماسة إلى دروس وعبر كربلاء ؛ ولذا ينبغي إيضاح تلك الدروس لشبابنا ومثقفينا
بأسلوب ولغة عصرية ، كي يتذوقوا هذه الدروس ويحصل لهم التفاهم المتبادل للوصول للغاية المنشودة ، وأحسن الطرق في هذا المجال ما نهجه علماء التربية في تتهذيب أخلاق النشئ وتقويمها ، وهي طريقة المثال الأعلى ـ وذلك بتقديم سِيَر الأبطال ورجال الفضيلة بصورة تجذب عواطفهم وتملك قلوبهم ، فيجعلون صورة أولئك الأشخاص أبداً نصب أعينهم ، فيجتهدون في تقليدها والسير على منوالها ، فما أحوجنا اليوم إلى شباب يتعلمون من مدرسة الحسين عليه السلام وتضحيته على أرض كربلاء ، وهذا ما نراه واضحاً في روايات أهل البيت عليهم السلام من الحث والتأكيد على قضية الحسين عليه السلام ، ومن الأمور التي إعتنت بها هذه الروايات ذكر أسماء البقعة الطاهرة التي إرتبطت به وبنهضته المقدسة ، وسار على هذا النهج رجال الحديث والفقه ؛ حيث ركزوا على بعض أسماء كربلاء ، كالحائر والحرم وتربة الحسين ؛ لإحتياجهم إليها في البحث الفقهي ، وكذلك المؤرخون والشعراء ، وبعد بيان كل ذلك ؛ ظهرت أهمية الموضوع ـ وهو (أسماء التربة في الروايات) ـ وما يترتب عليه من فوائد.
تساؤلات البحث :
لعلّ من أهم التساؤلات في هذا البحث ؛ هو التالي :
ذكرت الروايات أسماء عديدة للتربة الحسينية ـ على مُشرِّفها آلاف التحية والسلام ـ ، فما الهدف من ذلك؟
منهج وأسلوب البحث :
إهتم الباحثون بأسماء هذه التربة المقدسة ، نذكر ممنهم على سبيل المثال ما يلي :
١ ـ ياقوت الحموي في موسوعته : (معجم البلدان) ، حيث ذكر بعض أسمائها من الناحية التاريخية.
٢ ـ العلامة الشيخ عبد الواحد المظفر ، في موسوعته : (بطل العلقمي ـ في الجزء الثالث) ، حيث ذكر أشهر أسمائها وبحثها بحثاً علمياً.
٣ ـ الدكتور عبد الجواد الكليدار في : (تاريخ كربلاء وحائر الحسين عليه السلام) ، حيث قام بدراسة حول الحائر الحسيني من الناحية التاريخية واللغوية والفقهية.
٤ ـ الكاتب جعفر الخليلي في موسوعته (العتبات المقدسة ـ قسم كربلاء) ، حيث قام بدراسة لأشهر أسمائها ، ولكن الذي يتميز به بحثنا ، هو تتبع ما ذكر من أسمائها في الروايات ، وسيكون البحث متكوناً من بحثين كالتالي :
الأول ـ التربة في الروايات :
ويتناول الأبحاث التالية :
أولاً ـ التعرض للأسماء القديمة التي أطلقت على البقعة الطاهرة ـ كما ورد في الروايات ـ ، كالطف وكربلاء ونينوى ونحوها ، وكذلك الأسماء المحدثة قبل مقتل الحسين عليه السلام وبعده ، مثل : كرب وبلاء ، والتربة والطينة ، وحرم الحسين ، ونحو ذلك.
ثانياً ـ إنّ الأسماء المذكورة وإن كانت غير مختصة بمنطقة واحدة ـ إذ أنها من القرى التي كانت تحيط بكربلاء عند ورود الحسين عليه السلام لها ـ إلا أننا نذكر هذه الأسماء باعتبارها واقعة في حرم الحسين عليه السلام الذي حددته الروايات إلى خمسة فراسخ ، فهي أسماء لهذه البقعة الطاهرة بالنتيجة.
ثالثاً ـ ذكر الإسم والتعريف به من حيث سبب التسمية والموقع ، ثم ذكر الروايات النّاصة عليه.
رابعاً ـ دراسة بعض الأسماء التي ذكرتها الروايات ومثال ذلك ؛ روضة من رياض الجنة ، وترعة من ترع الجنة ، والحائر ونحو ذلك ، مع بيان الفوائد المتعلقة بها.
خامساً ـ قسمت هذه الأسماء إلى ثلاثة أقسام كالتالي :
الأول ـ أسماء شرف وقداسة : وهي الأسماء التي أُطلقت وكان الهدف منها العناية الإلهية ؛ أي لها إرتباط بالدين ومثال ذلك : أرض الله المقدسة ، والحائر ، وبطحاء الجنة ، وقبة الإسلام ، وتربة الحسين ، ونحو ذلك.
الثاني ـ أسماء تاريخية : وهي الأسماء التي أطلقت وعرفت تاريخياً ، وأدرجنا في ضمنها بعض الأسماء التي عرفت لمناسبة معينة ، ومثال ذلك : العقر ، ونينوى ، والنواويس ، والغاضرية ، ونحو ذلك.
الثالث ـ أسماء طبيعية : وهي الأسماء التي أطلقت وعرفت لمناسبة ترجع إلى طبيعة الأرض وصفتها ولونها ، ومثال ذلك : أرض فلاة ، وبطحاء ، والتربة ، والطينة ، والطف ، ونحو ذلك.
سادساً ـ رتبت الأسماء المذكورة حسب الترتيب الهجائي في كل قسم على حِدَه.
الثاني ـ نتائج البحث :
ويتناول أهم الفوائد والأبحاث المستفادة من الروايات المذكورة ، التي يمكن تصنيفها كالتالي :
١ ـ إهتمام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بالتربة الحسينية.
٢ ـ إهتمام الملائكة بالحسين عليه السلام وتربته.
٣ ـ إهتمام الأنبياء بالحسين عليه السلام وتربته.
٤ ـ تقديس التربة والتبرك بها.
٥ ـ خصائص التربة الحسينية.
٦ ـ المجاورة في كربلاء والأماكن المقدسة.
وختمت البحث بأجوبة التساؤلات ، هذا ما أردت بحثه ، والله ولي التوفيق والسداد.
أمين بن الحاج حبيب آل درويش
الملّاحة ـ القطيف
الخمييس ١٧ / ٣ / ١٤٢٣ هـ
الموافق للمولد النبوي الشريف
البحث الأول
أسماء التربة في الروايات
بحوث تمهيدية
ـ الجانب اللغوي للإسم
ـ الجانب الديني للإسم
ـ الجانب الإجتماعي للإسم
الجانب اللغوي للإسم
أ ـ إشتقاق الإسم.
ب ـ معنى الإسم.
ج ـ أقسام الإسم.
أ ـ إشتقاق الإسم :
ذكر الفقيه المحقق السيد السبزواري (قده) : «إسم : أصله من السمو ـ مخففة ـ بمعنى الرفعة ، ومنه السماء ، ويصح أن يكون إشتقاقه من السِمَة بمعنى العلامة ، والهاء عوض الواو فيكون أصله الوسم ، فالوسم والوسام بمعنى العلامة.
والهمزة : همزة وصل على التقديرين ، ويصح الإشتقاق من كل منهما ؛ لأنّ التبديل والتغيير في حروف الكلمة جائز ما لم يضر المدلول ، إلا أن يكون اللفظ بخصوص شخصه سماعياً. ومن وقوع التغيير والتبديل في هذا اللفظ في الإشتقاقات الصحيحة ، وسهولة لغة العرب نستفيد صحة ما تقدم.
ويصح رجوع أحد المعنيين إلى الآخر في جامع قريب ـ وهو البروز والظهور ـ ؛ لأنّ الرفعة نحو علامة ، والعلامة نحو رفعة لذيها ، وهما يستلزمان البروز والظهور. ودأب اللغويون والأدباء ـ وتبعهم المفسرون على جعل المصاديق المتعددة مع وجود جامع قريب مختلف المعنى ، مكثرين بذلك المعاني ، غافلين عن الأصل الذي يرجع الكل إليه ، فكان الأجدر بهم بذل الجهد في بيان الجامع القريب ، والأصل الذي يتفرع منه ، حتى يصير بذلك علم اللغة أنفع مما هو عليه»(٣) .
ب ـ معنى الإسم :
عُرِّف الإسم بعدة معانٍ أهمها ما يلي :
١ ـ ما ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام : (فالاسم ما أنبأ عن المسمى)(٤) .
__________________
(٣) ـ السبزواري ، السيد عبد الأعلى الموسوي : مواهب الرحمن ، ج ١ / ١٢.
(٤) ـ الصدر ، السيد حسن : تأسيس الكرام لعلوم الإسلام / ١٤٩.
٢ ـ ما ذكره أهل اللغة : «هو رسم وسِمَة توضع على الشيء تعرف به»(٥) .
٣ ـ عند النحاة : «ما دَلّ على معنى في نفسه مجرداً من الزمن ، أو ما صلح لأن يكون مسنداً إليه ومسند»(٦) .
أو بعبارة أخرى : ما يقابل الفعل والحرف. ويتميز الإسلام بعلامات مُعيّنة حددها النحاة ، من خلال الإستعمال اللغوي ، وهي خمس : الجر ، والتنوين ، والنداء ، والإسناد إليه ، ودخول (ال) التعريف عليه.
ج ـ أقسام الإسم :
قَسّم النحاة الإسم إلى عدة تقسيمات ولكن أهمها ما يلي :
الإسم قسمان : موصوف وصفة.
أ ـ الموصوف : ما دل على شيء يمكن أن يوصف ، مثل رجل ، وباب ، ويقسم إلى قسمين :
١ ـ إسم ذات : ويسمى اسم عين أيضاً ، وهو ما دل على ذات محسوسة ، مثل : (أرض).
٢ ـ إسم معنى : وهو ما دل على معنى قائم في الذهن ، مثل (شجاعة ، رجوع). ويدخل في قسم الموصوف ، المصدر وأسماء الزمان والمكان والآلة.
ب ـ الصفة : ما دل على صفة قائمة بالذات أو بالمعنى ، مثل : (طويل ، عريض) ، ويدخل في هذا القسم إسم الفاعل : (جاء الرجل العالم) ، وإسم المفعول : (جاء الرجل المعروف) ، والصفة المشبهة : (جاء الرجل الكريم) ، وإسم التفضيل : (جاء الرجل الأكرم) ، والمصدر الموصوف به :
__________________
(٥) ـ ابن منظور ، محمد بن مكرم : لسان العرب ، ج ١٤ / ٤٠١.
(٦) ـ شريف ، الدكتور محمد أبو الفتوح : التركيب النحوي وشواهده القرآنية ، ج ١ / ٢٣.
(جاء رجلٌ عدلٌ) ، والإسم الجامد المتضمن معنى الصفة المشتقة : (جاء الرجل الأسد) ؛ أي الشجاع ، والإسم المنسوب (جاء الرجل الدمشقي)(٧) وركزنا على هذا التقسيم باعتباره محل حاجتنا في هذا البحث.
وقَسّمه أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : (واعلم يا أبا الأسود ، أنّ الأسماء ثلاثة : ظاهر ، ومضمر ، واسم لا ظاهر ولا مضمر ، وإنما يتفاضل الناس فيما ليس بظاهر ولا مضمر ، وأراد بذلك الإسم العلم المبهم)(٨) .
«قال الزجاج : قوله عليه السلام : ظاهر ، ومضمر ، وشيء ليس بظاهر ولا مضمر ، فالظاهر : رجل ، وزير وعمرو ، وفرس وما شابه. والمضمر : أنا ، أنت ، وألتاء في فعلتُ ، والياء في غلامي ، والكاف في ثوبك ، وما شابه. وأما الشيء الذي ليس بظاهر ولا مضمر ؛ فهو المبهم ، هذا ، هذه ، هاتا وتا ، ومن ، وما ، والذي وأيّ ، وكم ، ومتى ، وأين وما شابه»(٩) .
__________________
(٧) ـ الأنطاكي ، محمد : المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها ، ج ١ / ١٨٩ ـ ١٩٠.
(٨) ـ الصدر ، السيد حسن : تأسيس الكرام لعلوم الإسلام / ١٤٩.
(٩) ـ الشفائي ، حسين علي : قضاء الإمام أمير المؤمنين (ع) / ١٠٨.
الجانب الديني للإسم
أولاً ـ أسماء الله الحسنى
ثانياً ـ أسماء الأنبياء والأوصياء
ثالثاً ـ أسماء الأشياء
إنّ هذا الجانب من البحث غني بالفوائد ؛ إلا أنّ أهم ما يمكن بحثه ـ هنا ـ هو التالي :
أولاً ـ أسماء الله الحسنى :
إنما سميت حسنى لحسن معانيها ، والمعنى في كون أسمائه أحسن الأسماء أنها تنبئ عن صفات حسنة كالقادر والعالم ، وعن أفعال حسنة كالخالق والرازق ، وعن معاني حسنة كالصمد فإنه يرجع إلى أفعال عباده ، وهو أنّه يصمدونه في الحوائج ؛ أي يقصدونه. ويؤكد هذا المعنى ما جاء في الرواية التالية :
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : (سألته : هل كان الله عَزّ وجَلّ عارفاً بنفسه قبل أن يخلق الخلق؟
قال عليه السلام : نعم. قلت : يراها ويسمعها؟ قال : ما كان محتاجاً إلى ذلك ؛ لأنه لم يكن يسألها ولا يطلب منها ، هو نفسه ونفسه هو ، قدرته نافذة ، فليس يحتاج أن يُسمِّي نفسه ، ولكنّه إختار لنفسه أسماء لغيره يدعوه بها ؛ لأنّه إذا لم يدع باسمه لم يعرف ، فأوّل ما اختار لنفسه «العلي العظيم» ؛ لأنّه أعلى الأشياء كلها ، فمعناه الله ، وإسمه العلي العظيم ، وهو أوّل أسمائه ؛ لأنّه عليٌّ علا كلّ شيء)(١٠) .
والذي يهمنا ـ هنا ـ على نحو السرعة ، هو الإجابة على السؤالين الآتيين :
١ ـ كم عدد أسماء الله الحسنى؟
يتضح لنا الجواب على هذا السؤال بعد بيان ما يلي :
__________________
(١٠) ـ الصدوق ، الشيخ محمد بن علي بن الحسين : معاني الأخبار / ٢.
قال العلامة الطباطبائي (قده) : «لا دليل في الآيات الكريمة على تعين عدد للأسماء الحسنى تتعين به ، ـ إلى أن قال ـ أن كل اسم في الوجود هو أحسن الأسماء في معناها ، فهو له تعالى فلا تتحدد أسماءه الحسنى ، والذي ورد منها في لفظ الكتاب الإلهي مائه وبضعة (١٢٧) وعشرون إسماً»(١١) .
وأما ما ورد في الروايات التي رواها العامة والخاصة في حصرها في (٩٩) ، فنذكر منها ما يلي :
١ ـ روى الصدوق بإسناده عن الرضا عليه السلام ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لله عَزّ وجَلّ تسعة وتسعون إسماً ، من دعا الله بها إستجاب له ، ومن أحصاها دخل الجنّة)(١٢) .
٢ ـ عن أبي هريرة قال : (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن الله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحد ، من أحصاها دخل الجنة)(١٣) . وبعد ذكر هاتين الروايتين ؛ نخرج بالنتيجة التالية :
أولاً ـ قال الشيخ الكفعمي (قده) : «إنّ تخصيص هذه الأسماء بالذكر لا يدل على نفس ما عداها ؛ لأنّ في أدعيتهم عليهم السلام أسماء كثيرة لم تذكر في هذه الأسماء ، حتى إنّه ذكر أنّ الله تعالى ألفاً من الأسماء المقدسة المطهرة ، وروي أربعة آلاف ، ولعل تخصيص هذه الأسماء بالذكر لإختصاصها بمزية الشرف على باقي الأسماء ، أو لأنّها أشهر الأسماء وأبينها معاني وأظهر»(١٤) .
__________________
(١١) ـ الطباطبائي ، السيد محمد حسين : الميزان في تفسير القرآن ، ج ٨ / ٣٥٦ ـ ٣٥٧.
(١٢) ـ الصدوق ، الشيخ محمد بن علي : التوحيد / ١٩٥ (باب أسماء الله تعالى ـ الحديث ٩).
(١٣) ـ الترمذي ، محمد بن عيسى : صحيح الترمذي ، ج ٥ / ٥٣٠ (باب الدعوات ـ الحديث ٥٠٧).
(١٤) ـ الكفعمي ، الشيخ إبراهيم بن علي العاملي : البلد الأمين والدرع الحصين / ٦٩٦.
ويمكن القول : بأنّ (٩٩) لعلها أهم الأسماء وأنّها موجودة في القرآن الكريم ولو بمعناها ، وأما ما ذكره بعض المفسرين من كونها أكثر من ذلك ؛ فلاحظ أنها مكررة وترجع إلى معنى واحد ، فمثلاً (خير) قد تكرر في أكثر من مورد في القرآن الكريم : (خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ، خَيْرُ الرَّازِقِينَ ، خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ، خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ، خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ، خَيْرُ الْغَافِرِينَ ، خَيْرُ الْوَارِثينَ ، خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ، خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ، خَيْرُ النَّاصِرِينَ) ، وكذلك (شَدِيدَ) ورد في أكثر من مورد : (شَدِيدُ الْعَذَابِ ، شَدِيدُ الْعِقَابِ ، شَدِيدُ الْمِحَالِ).
ثانياً ـ ما ورد في رواية الصدوق المتقدمة أنّ الأسماء (١٠٠) وليست بـ(٩٩) فالظاهر أنّ لفظ الجلالة (الله) ذكر بعنوان المسمى الجاري عليه الأسماء ، وبذلك يستقيم العدد (٩٩) ، وبيان لك كالتالي :
ذكروا أنّ للفظ الجلالة أموراً يتميز بها عن بقية الأسماء الحسنى نذكره منها ما يلي :
١ ـ أنّه أشهر أسمائه تعالى ؛ إذ هو دال على الذات المقدسة الموصوفة بجميع الكمالات ، وباقي أسمائه تعالى لا تدل آحادها إلا على أحاد المعاني ، كالقادر على القدرة ، والعالم على العلم وهكذا البواقي.
٢ ـ إنّ جميع أسمائه الحسنى يتسمى بهذا الاسم ولا يتسمى هو بشيء منها ، فلا يقال : الله اسم من أسماء الصبور أو الرحيم أو الشكور ، ولكن يقال : الصبور اسم من أسماء الله تعالى. هذه بعض الوجوه التي إمتاز بها لفظ الجلالة على غيره من الأسماء الحسنى. ولخصها الشهيد الأول (قده) بقوله : «اسم للذات لجريان النعوت عليه ، وقيل : اسم للذات مع جملة الصفات
الإلهية ، فإذا قلنا : الله فمعناه الذات الموصوفة بالصفات الخاصة ؛ وهي صفات الكمال ونعوت الجلالة»(١٥) .
ثالثاً ـ قال الشيخ الصدوق (قده) : «معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (إنّ الله تبارك وتعالى تسعة وتسعين إسماً ، من أحصاها دخل الجنة) ، إحصاؤها : هو الإحاطة بها والوقوف على معانيها ، وليس معنى الإحصاء عَدّها ، وبالله التوفيق»(١٦) . وقال العلامة الطباطبائي (قده) : «والمراد بقوله : (من أحصاها دخل الجنة) الإيمان باتصافه تعالى بجميع ما تدل عليه تلك الأسماء ، بحيث لا يشد عنها شاذ»(١٧) .
الأسماء وظهورها في الخلق :
لعلّ المتتبع للآيات القرآنية ، يلاحظ أنها تهتم بالإسم المبارك ، نذكر منها : قوله تعالى : ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ) [العلق / ١] ، وقوله تعالى : ( فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ) [الواقعة / ٧٤]. وقوله تعالى : ( وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ) [الأعراف / ١٨٠]. فلماذا هذا الإهتمام بالإسم المبارك؟
الجواب على هذا السؤال يتضح فيما يلي :
أولاً ـ إنّ الحكمة العليا لخلق جميع المخلوقات ؛ هي أن يتجلى الرب سبحانه وتعالى لها بما هو متصف به من صفات الكمال ، ليعرف ويعبد ، ويشكر ويحمد ، ويحكم ويجزي فيعدل ، ويغفر ويعفو ويرحم الخ.
__________________
(١٥) ـ الشهيد الأول ، الشيخ محمد بن مكي العاملي : القواعد والفوائد ، ج ٢ / ١٦٦.
(١٦) ـ الصدوق ، الشيخ محمد بن علي : التوحيد / ١٩٥.
(١٧) ـ الطباطبائي ، السيد محمد حسين : الميزان في تفسير القرآن ، ج ٨ / ٣٥٩.
فهي مظهر أسمائه وصفاته ، ومجلى سننه وآياته ، وترجمان حمده وشكره ، لذلك كانت في غاية الإحكام والنظام ، الدالين على العلم والحكمة والمشيئة والإختيار ، ووحدانية الذات والصفات والأفعال.
وكان من مقتضى تحقق معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ، أن يخلق ما علمنا وما لم نعلم من أنواع المخلوقات ، وما يترتب على ذلك من حكم ومصالح.
ثانياً ـ قال الفيض الكاشاني (قده) : «وبالجملة أسباب وجود الخلائق ، وأرباب أنواعها التي بها خُلقت وبها قامت ، وبها رزقت فإنها أسماء الله تعالى ؛ لأنها تدل على الله بظهورها في المظاهر ، دلالة الإسم على المسمى ، فإنّ الدلالة كما تكون بالألفاظ كذلك تكون بالذوات ، من غير فرق بينهما فيما يؤول إلى المعنى ، وأسماء الله لا تشبه أسماء خلقه ، وإنما أضيفت في الحديث تارة إلى المخلوقات كلها ؛ لأنّ كلها مظاهرها التي فيها ظهرت صفاتها متفرقة ، وأخرى إلى الأولياء والأعداء ؛ لأنّهما مظاهرها التي فيها ظهرت صفاتها مجتمعة ؛ أي ظهرت صفات اللطف كلها في الأولياء ، وصفات القهر كلها في الأعداء ، وإلى هذا أشير في الحديث القدسي ـ الذي يأتي ذكره في تفسير آية سجود الملائكة لآدم عليه السلام ـ من قوله سبحانه (يا آدم هذه أشباح أفضل خلائقي وبرياتي ، هذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنا الحميد المحمود في فعالي ، شققت له إسماً من إسمي ، وهذا علي وأنا العلي العظيم ، شققت له إسماً من إسمي) ، إلى آخر ما ذكر من هذا القبيل ، فإنّ معنى الإشتقاق في مثل هذا ، يرجع إلى ظهور الصفات وإنباء المظهر عن الظاهر فيه ، أوهما سببان للإشتقاق أو
مسببان عنه ، وإنما يقول بالسببية مَن لم يفهم العينية ، والمراد بتعليم آدم الأسماء كلها خلقه من أجزاء مختلفة ، وقوى متباينة حتى إستعد لإدراك أنواع المدركات من المعقولات والمحسوسات والمتخيلات والموهومات ، وإلهامه معرفة ذوات الأشياء وخواصها ، وأصول العلم وقوانين الصناعات وكيفية آلاتها ، والتمييز بين أولياء الله وأعدائه ، فتأتي له بمعرفة ذلك كله مظهريته لأسماء الله الحسنى كلها ، وبلوغه مرتبة أحدّية الجمع التي فاق بها سائر أنواع الموجودات ، وروجعه إلى مقامه الأصلي الذي جاء منه ، وصار منتخباً لكتاب الله الكبير الذي هو العالم الأكبر ، كما قال أمير المؤنين عليه السلام : (وفيك انطوى العالم الاكبر)»(١) .
ثالثاً ـ ورد في بعض الآيات القرآنية : ( تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ) [الرحمن / ٧٨]. وفي دعاء الجوشن : (يا من تبارك اسمه) : قال الملا هادي السبزواري : «قيل معناه عظمت البركة في اسمه ، كما في : ( تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ) ، فاطلبوا البركة في كل شيء يذكر اسمه والحق في الاسم الشريف والآية أنه من باب التعظيم ؛ لأنّه إذا تعاظم وتبارك إسم الشيء ووجهه ، فنفسه بطريق أولى»(١٨) ومن هذا القبيل ما جاء في قوله تعالى : ( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ) [الأنعام / ١١٨]. فإنّ البركة في ذكر اسم الله تعالى في الأكل والشرب والذبح ونحو ذلك.
رابعاً ـ ورد في بعض الأدعية ـ كما في دعاء السحر ـ : «اَلّهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ مِنْ اَسمائِكَ بِاَكْبَرِها وَكُلُّ اَسْمائِكَ كَبيرَةٌ» ، وكما في غيره : «وبِأَسْمائِكَ
__________________
(١٨) ـ السبزواري ، الملا هادي بن مهدي : شرح دعاء الجوشن / ٦٦٧.
الَّتي مَلَاتْ اَرْكانَ كُلَّ شَيء» ، وأيضاً : «وبأسمائك التي تجليت بها للكليم على الجبل» ، فما المراد بها؟
أجاب الفقيه كاشف الغطاء (قده) : «المراد من أسماء في تلك الأدعية الشريفة ، المظاهر الإلهية التي يتجلى بها جلّ شأنه لخاصة أصفيائه في أزمنة خاصة ، وأمكنة مقدسة ، فالأسماء التي تجلى بها للكليم هي الظهورات التي ظهر بها الجليل على جبل طور سيناء ، أي الأنوار أو النار التي ظهرت للكليم ( فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ) [القصص / ٣٠] ، وتوجد الإشارة إلى كثير من هذه الظهورات في دعاء السمات ، الذي يقرأ عصر الجمعة وهو من الأدعية الجليلة ، وهذه هي الأسماء التي ملأت كل شيء ، فإنّ له تعالى في كل ظهور.
وفي كل شيء له آية |
تدل على أنه واحد»(١٩) |
وبعد هذا البيان إتضح لنا الجواب ، وظهرت أهمية الأسماء المباركة في مخلوقاته.
ثانياً ـ أسماء الأنبياء والأوصياء :
المشهور بين العلماء أنّ عدد الأنبياء عليهم السلام (١٢٤ ألف نبي) ، وأنّ سادتهم خمسة ـ وهم أصحاب الشرائع ـ نوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو أفضل الأنبياء. والقرآن الكريم ذكر بعضاً من أسمائهم وهم : آدم ، وادريس ، ونوح ، وهود ، وثمود ، وصالح ، وإبراهيم ، وإسماعيل ، ولوط ، ويعقوب ، ويوسف ، وأيوب ، وشعيب ، وموسى ، وهارون ،
__________________
(١٩) ـ كاشف الغطاء ، الشيخ محمد بن الحسين : جنة المأوى / ٢٤٩.
والياس ، واليسع ، وذو الكفل ، وداود ، وسليمان ، وزكريا ، ويحيى ، وعيسى ، ويونس ، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبقية الأسماء لم تذكر ، وإلى هذا تشير رواية أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : (كان ما بين آدم وما بين نوح من الأنبياء مستخفين ، ولذلك خفي ذكرهم في القرآن ، فلم يُسموا كما سمي من إستعلن من الأنبياء وهو قوله : ( وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ) (٢٠) »(٢١) . ولعلّ ذكر هذه الأنبياء دون غيرهم ، يدل على وجود أهمية لهم دون غيرهم ، وهذا ما نجده في القرآن الكريم من الجوانب والخصوصيات لهؤلاء الأنبياء ، وخصوصاً نبينا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، حيث تعددت أسماؤه كما أشار إلى ذلك الشيخ المجلس (قده) ، في بحث أسمائه وألقابه صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال : «سَمّاه في القرآن بأربعمأة إسم»(٢٢) . وبعد معرفة ذلك ؛ نخرج بالنتيجة التالية :
١ ـ إعتني الباري عَزّ وجَلّ بأسماء أنبيائه ، ، وسماهم بهذه الأسماء إهتماماً بشأنهم ومكانتهم عنده ، وإلى هذا تشير الآية المباركة : ( يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ) [مريم / ٧].
وإذا أمعنا النظر في هذه الآية ، يتضح لنا أنّ تعيين أسماء الأنبياء والأولياء يكون عن طريقه عَزّ وجَلّ ، ولم يكلها إلى الأبوين ، بل هم الأسماء الحسنى كما في الحديث المروي عن الإمام الصادق عليه السلام : (نحن ـ والله ـ الأسماء
__________________
(٢٠) ـ النساء / ١٦٤.
(٢١) ـ شبّر ، السيد عبد الله حق اليقين ج ١ / ١٨١.
(٢٢) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ١٦ / ١٠١.
الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملاً إلا بمعرفتنا)(٢٣) ، ويستفاد من هذا الحديث ما يلي :
أ ـ إنّ أسمائهم مشتقة من أسماء الله عَزّ وجَلّ ، كما في حديث الإمام الصادق عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام قال : (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ليلة اُسري بي إلى السماء صرت إلى سدرة المنتهى ، فقال لي جبرئيل : تقدم يا محمد ، فدنوت دنوّه ـ الدنوّة : مد البصر ـ فرأيت نوراً ساطعاً ، فخررت لله ساجداً ، فقال لي : يا محمد من خَلّفت في الأرض؟ فلت يا ربّ أعدلها وأصدقها وأبرها عليّ بن أبي طالب ، وصيي ووارثي وخليفتي في أهلي. فقال لي : أقرئه مني السلام وقل له : إنّ غضبه عزّ ، ورضاه حكم ، يا محمد أني الله لا إله إلا العلي الأعلى ، وهبت لأخيك إسماً من أسمائي فسميته علياً ، وأنا العلي الأعلى. يا محمد إني أنا الله لا إله إلا أنا فاطر السماوات والأرض ، وهبت لأبنتك إسماً من أسمائي فسميتها فاطمة ، وأنا فاطر كل شيء ، يا محمد ، إني أنا الله لا إله إلا أنا الحسن البلاء ، وهبت لسبطيك أسمين من أسمائي فسميتها الحسن والحسين ، وأنا الحسن البلاء ...)(٢٤) . وبعد ذكر هذا الحديث الشريف نطرح السؤال التالي :
س / ما وجه إشتقاق فاطمة من فَطَرَ؟
ج / إنّ الإشتقاق على ثلاثة أقسام كالتالي :
١ ـ الإشتقاق الصغير : وهو ما إذا كان الشمتقُّ والفرع مشتملين على حروف الأصل على الترتيب والنسق ، ومثال ذلك : (ضَرَبَ) فإنه مشتق من الضًّرْب).
__________________
(٢٣) ـ الكليني ، الشيخ محمد بن يعقوب : الكافي ، ج ١ / ١٤٤.
(٢٤) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٢٤ / ٣٢٣ ـ ٣٢٤.
٢ ـ الإشتقاق الكبير : وهو ما إذا لم يلحظ فيه الترتيب ، ومثال ذلك : (جَذَبَ وجَبَذً) فهما بمعنى واحد ؛ إذ معناها : المَدّ ، أو التنازع ، وقيل الجَبْذ ، لغة تميم ، ومادة اشتقاقها (ج ، ذ ، ب).
٣ ـ الإشتقاق الأكبر : وهو ما إذا لم يكن المشتق مشتملاً على جميع حروف الأصل ، ولكن فيه أكثر حروفه ، ومثال ذلك (فَطَم وفَطَر). وبعد هذا البيان إتضح لنا الجواب.
ب ـ إنّ أهل البيت عليهم السلام مظهر لجميع الأسماء الإلهية ، ويمكن الإستشهاد لذلك بما يلي :
١ ـ قال السيد الطباطبائي : «ورواه العياشي عنه عليه السلام : (وفيه أخذ الإسم بمعنى ما دَلّ على الشيء ، سواء كان لفظاً أو غيره ، وعليه فالأنبياء والأوصياء (عليهم السلام) ، أسماء دالة عليه تعالى ، وسائط بينه وبين خلقه ؛ ولأنّهم في العبودية بحيث ليس لهم إذا الله سبحانه ، فهم المظهرون لأسمائه وصفاته تعالى»(٢٥) .
٢ ـ ما جاء في حديث الراهب اليماني مع الإمام الكاظم عليه السلام : (فقال له أبو إبراهيم عليه السلام : فكم لله من إسم لا يُردّ؟ فقال الراهب : الأسماء كثيرة ، فأما المحتوم منها الذي لا يُردّ سائله فسبعة. فقال له أبو الحسن عليه السلام فأخبرني عَمّا تحفظ منها؟ فقال الراهب : لا والله الذي أنزل التوراة على موسى ، وجعل عيسى وعبرة للعالمين وفتنة لشكر أولي الألباب ، وجعل محمداً بركة ورحمة ، وجعل علياً عليه السلام عبرة وبصيرة ، وجعل الأوصياء من نسله ونسل محمد
__________________
(٢٥) ـ الطباطبائي ، السيد محمد حسين : الميزان في تفسير القرآن ، ج ٨ / ٣٦٧.
(صلى الله عليه وآله) ما أدري ولو دريت ما إحتجت فيه إلى كلامك ، ولا جئتك ولا سألتك)(٢٦) .
قال الشيخ عباس القمي (قده) : «إنّ المراد بالأسماء السبعة المعصومون عليهم السلام جميعهم ، ذلك أنّ أسمائهم المباركة هي سبعة لا تعدوها ، وهي : محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وجعفر وموسى عليهم السلام ، وعلى هذا جرى تأويل السبع المثاني ، في قوله تعالى : ( وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ) »(٢٧) .
وبعد هذا البيان ؛ إتضح لنا أن أسماء الأئمة الأطهار عليهم السلام حظيت بهذا الإهتمام الإلهي. وبعد هذا نطرح السؤال التالي :
س / لماذا لم يُنصّ على أسمائهم في القرآن الكريم ، حسماً للنزاع الفكري بين المسلمين في تحديد الأئمة بأسمائهم؟
ج / يتضح الجواب بعد بيان الوجهين التاليين :
الأول ـ ما أجاب به الإمام الصادق عليه السلام أبا بصير حينما سأله عن ذلك ، قال : (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عَزّ وجَلّ : ( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ) (٢٨) ؟ فقال : نزل في علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام. فقلت له : إن الناس يقولون : فماله لم يُسمِّ علياً وأهل بيته عليهم السلام في كتاب الله عَزّ وجَلّ؟ قال : فقال : قولوا لهم إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزلت عليه الصلاة ، ولمُ يُسمِّ لهم ثلاثاً ولا أربعاً ، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو
__________________
(٢٦) ـ الكليني ، الشيخ محمد يعقوب : أصول الكافي ، ج ١ / ٤٨١ ـ ٤٨٢.
(٢٧) ـ القمي ، الشيخ عباس : منتهى الآمال ، ج ٢ / ٢٥٥.
الذي فسّر ذلك لهم ، ونزلت عليه الزكاة ولم يسمِّ من كل أربعين درهماً درهم ، حتى كان رسول الله هو الذي فسّر ذلك لهم ، ...)(٢٩) .
الثاني ـ خلاصة ما أجاب به السيد عبد الحسين شرف الدين (قده) : «إنّ العرب عامة وقريشاً خاصة كانوا ينقمون من علي شدة وطأته ونكال وقعته ؛ إذ كان شديد الوطأة على أعداء الله ، عظيم الوقيعة فيمن يهتك حرمات الله ، كما قالت سيدة نساء العالمين في خطبتها عليها السلام : (وما الذي نقموا من أبي الحسن؟! نقموا والله نكير سيفه وشدة وطأته ، ونكال وقعته ، وتنمره في ذات الله). وإذا عرفت هذا كله تعلم أنّ أمر الإمامة كان حرجا؟ً إلى الغاية ؛ إذ أنها من أصول الدين فلا بد من تبليغها ، ولا مناص عن العهد بها إلى كفئها على كل حال ، ولهذا ولغيره اقتضت الحكمة تعيينه بآيات لم تكن على وجه الذي يحرج أولئك المعارضين ، وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يعهد بالإمامة إلى علي عليه السلام على وجه يراعي فيه الحكمة ، ويتحرى به المطابقة لمقتضى تلك الأحوال»(٣٠) .
ثالثاً ـ أسماء الأشياء :
تعتبر التسمية بصورة عامة من سنن الله تعالى في خلقه ، وقد سمى الله تعالى آدم وحَوّاء يوم خلقهما ، وعَلّم آدم الأسماء كلها كما في قوله تعالى : ( وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَـٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ) [البقرة / ٣١].
فاقتضت الحكمة والعناية الإلهية الإهتمام بأول خليقته ، حيث مَيّزه على سائر خلقه بهذا المقام الخطير ، بأن عَلّمه ما لم يعلم ، وجعل في نسله هذه القوة
__________________
(٢٩) ـ الكليني ، الشيخ محمد بن يقوب : أصول الكافي ، ج ١ / ٢٨٦ ـ ٢٨٧.
(٣٠) ـ شرف الدين ، السيد عبد الحسين : فلسفة الميثاق والولاية / ١٢ ـ ١٣ (بتصرف).
العلمية ، فكان في ذريته الأنبياء والأولياء ، وتفرّع على ذلك العلماء والعقلاء الذين سخروا العالم بعلمهم ، ودبروا البلاد بعقلهم ، وهذه الآية المباركة ذات جوانب كثيرة ، ولكن الذي يهمنا بحثه هو ما يلي :
١ ـ الجانب التفسيري :
المستفاد من روايات أهل البيت عليهم السلام ما يلي :
أ ـ عَلّمه الباري عَزّ وجَلّ أسماء الأشياء ، ويؤيد ذلك ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سُئل عن هذه الآية فقال : «الأرضين والجبال والشعاب والأودية ، ثم نظر إلى بساط تحته فقال : وهذا البساط مما عَلّمه)(٣١) .
ب ـ عَلّمه أسماء أهل بيت العصمة والطهارة ، ويؤيد ذلك ما روي عن إمامنا الصادق عليه السلام : (إنّ الله تبارك وتعالى عَلّم آدم عليه السلام أسماء حجج الله كلها ، ثم عرضهم ـ وهم أرواح ـ على الملائكة)(٣٢) . وأيضا يستفاد من قوله تعالى : ( أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَـٰؤُلَاءِ ) ، فإن ذكر (هَؤلاء) بعنوان الإشارة إلى الحاضرين ؛ أي أرواحهم لبيان رفعة مقامهم ـ صلوات الله عليهم ـ بالتعبير عن أسمائهم بالخصوص.
٢ ـ الجانب العلمي :
يستفيد علماء الأصول من هذه الآية الشريفة في بحث الوضع ، ويعنونون المسألة هكذا : هل الواضع هو الله ، أو البشر؟ والذي يهمنا بحثه ـ هنا ـ هو ما يستفاد من الآية في نشأة اللغة عند الإنسان ، بعد معلومية إنتهائها إلى الله عَزّ وجَل.
__________________
(٣١) ـ الحويزي ، الشيخ عبد علي بن جمعه : نور الثقلين ، ج ١ / ٧٤.
(٣٢) ـ الصدوق ، الشيخ محمد بن علي : إكمال الدين وإتمام النعمة / ١٤.
ولعلّ أهم الوجوه ما يلي :
١ ـ إنّ الله جعل في النفوس البشرية قوة الإلهام أن يطلقوا الألفاظ على طبق معانيها بمقدار حاجاتهم ، لا أنّ هناك واضعاً تنتظره البشرية حين نُطْقِها ، وتكون مُطَبَّقة لما وضعها من الألفاظ للمعاني(٣٣) .
٢ ـ إنها حصلت بتعليم الله عَزَ وجَلّ لآدم ، فانتشرت في ذريته بحسب مقتضيات الأزمنة والأمكنة ، إذ المستفاد من الآية الشريفة : أنّ المراد من الجمع ـ أي الأسماء ، والتأكيد الإضافي ـ ؛ أي كلهم ، ما كان في عصر آدم وما كان في مورد إحتياجه في مدة حياته ، ثم بعد ذلك إستحدثت لغات ولهجات ، وهذا الذي يمكن إستفادته من مجموع الروايات بعد رد بعضها إلى بعض ، وهو قريب من الأذهان ، وبه يمكن الجمع بين بعض الوجوه المتقدمة(٣٤) . هذا ما أردنا بحثه ـ هنا ـ رعاية للإختصار.
__________________
(٣٣) ـ الخاقاني ، الشيخ محمد بن الشيخ محمد : المحاكمات ، ج ١ / ١٣٣.
(٣٤) ـ السبزواري ، السيد عبد الأعلى الموسوي : مواهب الرحمن ، ج ١ / ١٨٣.
الجانب الإجتماعي للإسم
توطئة وتمهيد
إختيار الإسم الجميل
تبديل الأسماء المستقبحة
تأثير الإسم على شخصية الإنسان
تخليد أسماء العظماء
توطئة وتمهيد :
لو ألقينا نظرة حول التسمية بشكل عام ؛ لوجدناها من سنن الله عَزّ وجَلّ ، وقد سار الناس على هذه السنّة ، ولكن تختلف التسمية عند البشر على مَرّ الأجيال والعصور على إختلاف لغاتها ، فقد توجد مناسبة بين الإسم والمسمى ولا توجد ، وقد يكون للإسم معنى في قاموس اللغة وقد لا يوجد ، بل هو إسم مخترع لا من مادة لغوية ؛ ولذا نجد العادة جارية في القبائل العربية قبل ظهور الإسلام بتسمية أولادهم بأسماء الوحوش والجوارح ، وقد جاء في رواية أحمد بن أشيم ، عن الإمام الرضا عليه السلام : (قلت له : لِمَ تسمي العرب أولادهم بكلب وفهد ونمر وما أشبه ذلك؟ قال : كانت العرب أصحاب حرب ، وكانت تهول على العدو بأسماء أولادهم ، ويسمون عبيدهم : فرج ، ومبارك ، وميمون وأشباه هذا يتيمنون بها )(٣٥) . وبالرغم من أن تلك الأسماء كانت شايعة ومتداولة بينهم ، إلا إنّها كانت في بعض الأحيان ذريعة قوية للطعن والتحقير في أصحابها ، وعلى سبيل المثال : ما حصل لأحد رؤساء عشاير الشام ـ يسمى جارية بن قدامة ـ وكان رجلاً قوياً صريح اللهجة ، وكان يبطن لمعاوية حقداً وعداً ، وسمع معاوية بذلك فأراد أن يحتقره أمام ملأ من الناس ، ويتخذ إسمه وسيلة للإستهزاء والسخرية منه ، وصادف أن إلتقيا في بعض المجالس ، فقال له معاوية : «ما كان أهونك على قومك إذ سموك جارية؟! فقال له جارية : وما كان أهونك على قومك إذا سموك معاوية ؛ وهي الأنثى من الكلاب؟!»(٣٦) .
__________________
(٣٥) ـ الحر العاملي ، الشيخ محمد حسن : وسائل الشيعة ، ج ٢١ / ٣٩٠ من أبواب أحكام الأولاد ـ الحديث ٥).
(٣٦) ـ الأبشيهي ، شهاب الدين محمد بن أحمد : المستطرف في كل فن مستطرف ، ج ١ / ٩١.
إذن ، من المظاهر المهمة لدى كل إنسان إسمه وإسم عشيرته ، فكما أنّ صورة الشخص سبب لإستحضاره في أذهان الناس ، كذلك إسمه فإنه يعطي صورة عنه ، وكما أنّ الإنسان يلتذ من صورته الجميلة ويتألم منها إن كانت قبيحة ، كذل يَستَرّ من الإسم الجميل ، ويتأذى من الإسم القبيح له أو لعشيرته ؛ ولأهمية الإسم سنبحثه من الجوانب الآتية :
إختيار الإسم الجميل :
إعتني الإسلام بالتسمية وجعلها من حقوق الأولاد على الآباء ، وقد ورد الحث على هذا في الروايات التالية :
روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (من حق الولد على الوالد أن يحسن إسمه ويحسن أدبه)(٣٧) .
وروي عن الإمام الكاظم عليه السلام : (إنّ أول ما يبَر الرجل ولده أن يسميه بإسم حسن ، فليحسن أحدكم إسم ولده)(٣٨) .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (إستحسنوا أسماءكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة)(٣٩) . وأحسن الأسماء أهل بيت العصمة عليهم السلام ، فقد ورد في الزيارة الجامعة : (فما أحلى أسماءكم ، وأكرم أنفسكم).
وعن أبي جعفر صلى الله عليه وآله وسلم : (أصدق الأسماء ما يسمى بالعبودية ، وأفضلها أسماء الأنبياء)(٤٠) .
__________________
(٣٧) ـ النوري ، ميرزا حسين الطبرسي : مستدرك الوسائل ، ج ١٥ / ١٢٨ ـ ١٢٩ (باب ١٥ من أبواب أحكام الأولاد ـ حديث ٢).
(٣٨) ـ الكليني ، الشيخ محمد يعقوب : الكافي ، ج ٦ / ١٨ (باب الأسماء والكنى ـ حديث ٣).
(٣٩) ـ نفس المصدر / ج ٦ / ١٩ (باب الأسماء والكنى ـ حديث ١٠).
(٤٠) ـ نفس المصدر / ج ٦ / ١٨ (باب الأسماء والكنى ـ حديث ١).
تبديل الأسماء المستقبحة :
عندما نلقي نظرة عابرة على الأسماء المتداولة في المجتمعات التي تعيش في القرى أو المدن ؛ نجد فيها أسماء وألقاباً قبيحة قد يؤدي التصريح بها في المجالس إلى السأم والضجر بالنسبة إلى البعض ، ومن هذا المنطلق نرى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يغير الأسماء المستهجنة للأفراد والبلدان ، كما تشير الروايات الآتية :
١ ـ الإمام الصادق عليه السلام ، عن أبيه قال : (كان رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ يُغيِّر الأسماء القبيحة في الرجال والبلدان)(٤١) .
٢ ـ عن أب يرافع : (إنّ زينب بنت أم سلمة كان إسمها برّة ، فقيل تزكي نفسها فسمّاها رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ زينب)(٤٢) .
٣ ـ عن ابن عمر : (أنّ إبنة لعمر كان يقال لها عاصية ، فسَمّاها رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ جميلة)(٤٣) .
وبعد إستعراض هذه النصوص ؛ نستفيد أنّ الإسلام يكره للمسلمين هذه الأسماء المستقبحة ، تنبيهاً على حفظ كرامة المسلم ، لكي لا يقع معرضاً لتحقير الآخرين وإهانتهم ، ومع هذا نهى الإسلام عن ذكر الناس بإسم أو لقب يشينهم ، ويكون سبباً لإهانتهم وتحقيرهم ، وما يؤدي ذلك إلى زرع البغضاء والحقد بين أفراد المجتمع ، وإلى هذا تشير بعض الروايات كالتالي :
محمد بن يحيى بن أبي عباد قال : حدثني عَمَّي قال : (سمعت الرضا عليه السلام يوماً سنشد ، وقليلاً ما كان ينشد شعراً :
__________________
(٤١) ـ الحميري ، أبي العباس عبد الله بن جعفر : قرب الإسناد / ٩٣ (حديث ٣١).
(٤٢) ـ مسلم ، مسلم بن الحجاج : صحيح مسلم ، ج ٦ / ١٧٣.
(٤٣) ـ نفس المصدر.
كلّنا نأمل مداً في الأجل |
والمنايا هنّ آفات الأمل |
|
لا تغرنك أباطيل المنى |
والزم القصد ودع عنك العلل |
|
إنما الدنيا كظل زائل |
حَلّ في راكب ثمّ رحل |
فقلت : لمن هذا أعزّ الله الأمير؟ فقال : لعراقي لكم ، قلت أنشدنيه أبو العتاهية لنفسه ، فقال : هات إسمه ودع هذا ، إنّ الله سبحانه يقول : ( وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ) (٤٤) . ولعلّ الجل يكره هذا(٤٥) وفي الحديث : (حق المؤمن على أخيه أن يسميه بأحب أسمائه)(٤٦) .
تأثير الإسم على شخصية الإنسان :
إنّ للإسم واللقب والكنية تأثيراً على شخصية الإنسان رفعة وضعة ، فالأشخاص الذين يمتازون بأسماء جميلة ، أو ينتمون إلى عشيرة ذات إسم جميل ، يفتخرون بذلك ويذكرونه بكل إرتياح ، بل لربما تفأل به السامع ، ومن الشواهد على ذلك : «حينما جاءت حليمة السعدية إلى مكة تطلب طفلاً ترضعه ، سمعت عبد المطلب ينادي بأعلى صوته : (هل بقي من الرضّاع أحد؟ فإن عندي بُنيّاً لي يتيماً ، وما عند اليتيم من الخير ، إنما يلتمس كرامة الآباء ، قالت : فوقفت لعبد المطلب ـ وهو يومئذ كالنخلة طولاً ـ ، فقلت : أنعم صباحاً أيها الملك المنادي ، عندك رضيع أرضعه؟ فقال هَلمّي ، فدنوت منه فقال لي : من أين أنت؟ فقلت : إمرأة من بني سعد. فقال لي : إيه إيه كرم
__________________
(٤٤) ـ الحجرات / ١١.
(٤٥) ـ الصدوق ، الشيخ محمد بن علي : عيون أخبار الرضا ، ج ١ / ١٩٠.
(٤٦) ـ الطريحي ، الشيخ فخر الدين : مجمع البحرين ، ج ٤ / ٣٧.
وزجر ، ثم قال لي : ما أسمك؟ فقلت حليمة فضحك وقال : بَخّ بخّ ، خلتان حَسَنَتان : سعد وحلم ، هاتان خلّتان فيها غنى الدهر ...)(٤٧) .
أما الذين يحملون أسماء مستهجنة ، أو ينتمون إلى قبيلة ذات إسم قبيح ، فيحسون بالحقارة وضعف الشخصية وعدم الكفاءة وفقدان الإرادة ، وما أكثر الرجال من العلماء والمثقفين ، الذين كانت لهم الكفاءة لتسنّم مناصب عالية ، والحصول على مكانة شامخة في المجتمع ، لكنهم فقدوا جميع قيمهم الإجتماعية ، على أثر لقب قبيح أو شهرة سيئة ، ومن الشواهد على ذلك : «فقد كان إسحاق ابن إبراهيم ـ المعروف بابن النديم ـ من العلماء الذين قَلّ نظراؤهم في عصره ، وكان قد أجهد نفسه في علوم كثيرة : كالكلام والفقه والنحو والتاريخ واللغة والشعر ، وبرع في جميع ذلك براعة تامة ، وكان عملاقاً عظيماً في المناظرات العلمية ، وكثيراً ما كان يتغلب على فضلاء عصره ، وله في مختلف العلوم ما يقرب من أربعين مجلداً ، وآثاره المهمة باقية حتى اليوم. كان ابن النديم ذات صوت جميل ، ورغبة شديدة في الغناء ، وكثيراً ما يشترك في مجالس طرب الخلفاء ورجال الدولة ، ويؤنس الحاضرين بغنائه المطرب ، ويجذب قلوبهم نحوه ولإستمراره في هذا العمل ؛ ضؤلت قيمة ثقافته العلمية شيئاً فشيئاً بالنسبة إلى عنائه ، حتى عرف في المجتمع بهذه الصفة ، ولَقّبه الناس بـ(المغني والمطرب) ، لقد أوردت هذه الشهرة ضربة قاصمة على شخصيته ، ولم يتمكن فيما بعد أن يعدّ نفسه في المجتمع كرجل عالم مطلع ، وأن يظهر كفاءته العلمية وبالرغم من قربه لدى الخلفاء والشخصيات ، فإنهم لم
__________________
(٤٧) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ١٥ / ٣٨٨.
يعهدوا إليه بمهمة أو عمل خطير في الدولة ، وذلك حذراً من اضطراب الرأي العام.
وبهذا الصدد كان المأمون العباسي يقول : لو لم يكن يشتهر ابن النديم بالطرب والغناء لوليته القضاء ؛ لأنّه يفوق جميع قضاة الدولة الموجودين من حيث الفضل والعلم ، وأكثرهم إستحقاقاً لهذا المنصب»(٤٨) .
إذن ، نستنتج مما تقدم أنّ الاسم له تأثير على شخصية الإنسان ، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى تنغص الحياة عليه ، ومن هذا المنطلق على الآباء أن يختاروا لأولادهم الأسماء المناسبة الجميلة ، وألا يكونوا سبباً لشعورهم بالخسّة والضعة طيلة حياتهم.
تخليد أسماء العظماء :
إنّ إحياء وتخليد أسماء العظماء أمر يهتم به العقلاء في الشرق والغرب ، وهذا ما نراه واضحاً في حياتهم ، فالحكومات تقوم بتسمية المدن والجامعات والشوارع بأسماء عظمائها ، وبهذه الطريقة خلدوا أسماءهم.
ولو إستعرضنا نصوص أهل البيت عليهم السلام ؛ لوجدنا أنهم أوصوا أتباعهم بتسمية أولادهم بأسماء القادة الإلهيين كالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام ، ومن بين تلك النصوص ما يلي :
١ ـ عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من ولد له أربعة فلم يسم بعضهم باسمي ، فقد جفاني )(٤٩) .
__________________
(٤٨) ـ فلسفي ، الشيخ محمد تقي : الطفل بين الوراثة والتربية ، ج ٢ / ١٧٥ ـ ١٧٦.
(٤٩) ـ النوري ، ميرزا حسين الطبرسي : مستدرك الوسائل ، ج ١٥ / ١٣٠ (باب من أبواب أحكام الأولاد ـ حديث ١).
٢ ـ عن أبي رافع قال : (سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : إذا سميتم محمداً فلا تقبحوه ولا تجبّهوه ولا تضربوه ، بورك بيت فيه محمد ، ومجلس فيه محمد ، ورفقة فيها محمد )(٥٠) .
٣ ـ عن الباقر عليه السلام : (إنّ الشيطان إذا سمع منادياً ينادي يا محمد ، ذاب كما يذوب الرصاص ، حتى إذا سمع منادياً ينادي باسم عدو من أعدائنا ؛ إهتزّ وإختال )(٥١) .
٤ ـ عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال : (لا يدخل الفقر بيتاً فيه إسم محمد ، أو أحمد ، أو علي ، أو الحسن ، أو الحسين ، أو جعفر ، أو طالب ، أو عبد الله ، أو فاطمة من النساء )(٥٢) .
٥ ـ عن ربعي بن عبد الله قال : (قيل لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ، إنّا لنسمي بأسمائكم وأسماء آبائكم فينفعنا ذلك؟ فقال : إي والله ، وهل الدّين إلا الحب والبغض! قال الله تعالى : ( إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ) (٥٣) )(٥٤) . وبعد هذه النصوص ؛ نخرج بالنتيجة التالية :
__________________
(٥٠) ـ المصدر السابق : (باب ١٦ ـ حديث ٢).
(٥١) ـ الحر العاملي ، الشيخ محمد بن الحسن : وسائل الشيعة ، ج ٢١ / ٣٩٣ (باب ٢٤ من أبواب أحكام الأولاد ـ حديث ٣).
(٥٢) ـ نفس المصدر / ٣٩٦ (باب ٢٦ من أبواب أحكام الأولاد ـ حديث ١).
(٥٣) ـ آل عمران / ٣١.
(٥٤) ـ النوري ، ميرزا حسين الطبرسي : مستدرك الوسائل ، ج ١٥ / ١٢٨ ـ ١٢٩ (باب ١٥ من أبواب أحكام الأولاد ـ حديث ١).
إنّ الآباء والأمهات الذين سَمّوا أولادهم بأسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وأهل بيته الكرام عليهم السلام ، قد حققوا أمرين مهمين :
أولاً ـ تخليد أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام ، وما يترتب على ذلك من إظهار الولاء والمحبة لهم ، لما في ذلك من الخير والبركة والأجر والمثوبة.
ثانياً ـ حفظوا أولادهم من الإحساس بالحقارة ؛ لأنّ أسماءهم عليهم السلام من أجمل وأفضل الأسماء ، التي إختارها لهم الباري عَزّ وجَلّ ، فهي محل فخر وإعتزاز لمن تَسَمّى بها.
الفصل الأول
أسماء شرف وقداسة
١ ـ أرش الله المقدّسة
٢ ـ أطهر بقاع الأرض
٣ ـ أكرم أرض الله
٤ ـ البقعة الطيبة
٥ ـ بقعة كثيرة الخير
٦ ـ البقعة المباركة
٧ ـ بطحاء الجنة
١ ـ أرض الله المقدّسة :
هذا الإسم نصّت عليه بعض الروايات كالتالي :
١ ـ عن صفوان الجمّال قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : (إن الله فَضّل الأرضين والمياه بعضها عن بعض ، فمنها ما تفاخرت ومنها ما بغت ، فما من أرض ولا ماء إلا عوقبت لترك التواضع لله ، حتى سَلّط الله على الكعبة المشركين ، وأرسل إلى زمزم ماءاً مالحاً فأفسد طعمه ، وأن كربلاء وماء الفرات ، أوّل أرض وأوّل ماء ، قَدّس الله وبارك عليه ، فقال لها : تكلمي بما فضلك الله ، فقالت : أنا أرض الله المقدّسة المباركة ، الشفاء في تربتي ومائي ولا فخر ، بل خاضعة ذليلة لمن فعل بي ذلك ، ولا فخر على من دوني بل شكراً لله ، فأكرمها وزادها بتواضعها وشكرها لله بالحسين وأصحابه ، ثم قال أبو عبد الله ـ عليه السلام ـ : من تواضع لله رفعه ، ومن تَكبّر وضعه الله)(٥٥) .
٢ ـ عن أبي الجارود قال : قال علي بن الحسين ـ عليهما السلام ـ : (إتخذ الله أرض كربلاء حرماً آمناً مباركاً قبل أن يخلق أرض الكعبة بأربعة وعشرين ألف عام ، وأنها إذا بَدّل الأرضين رفعها كما هي برمتها نورانية صافيه ، فجعلت في أفضل روضة من رياض الجنة ، وأفضل مسكن في الجنة ، لا يسكنها إلا النبيون والمرسلون ـ أو قال : أولوا العزم من الرسل ـ ، وإنها لتزهر من رياض الجنة كما يزهر الكوكب الدّري لأهل الأرض ، يغشى
__________________
(٥٥) ـ الحر العاملي ، الشيخ محمد حسن : وسائل الشيعة ، ج ١٠ / ٤٠٤ (باب ٦٨ استحباب التبرك بكربلاء ـ حديث ٤).
نورها نور أبصار أهل الجنة جميعاً ، وهي تنادي : أنا أرض الله المقدسة ، والطينة المباركة ، التي تضمنت سيد الشهداء وشبان الجنة)(٥٦) .
بحث في تفضيل كربلاء على الكعبة :
يستفاد من الحديثين المذكورين تفضيل كربلاء على أرض الكعبة ، وقد تقدم البحث عن ذلك في الجزء الأول. والذي نريد بحثه ـ هنا ـ هو ما يلي :
الأول ـ الأعوام والسنون في الآيات والروايات :
س ١ / ما هو المراد بالأعوام والسنيين في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث؟
ج / يتضح الجواب بعد بيان المقدمة التالية :
أولاً ـ إنّ أفعال الله سبحانه مبنيّة على الحِكَم والمصالح ، وإنّ كمته إقتضت أن تكون أفعاله بالنسبة إلى مخلوقاته على قسمين :
١ ـ ما يصدر عنه على نحو السرعة وبدون توقفه على مادة أو مدة زمنية ، كما أشار إلى ذلك في قوله تعالى : ( وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ) [البقرة / ١١٧]. وهذا كناية عن نهاية السرعة في الخلق والإيجاد.
٢ ـ ما يصدر عنه بعد مدة زمنية وعلى نحو التدريج ، ومن هذا خلق السماوات والأرض ، كما في قوله تعالى : ( إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ) [الأعراف / ٥٤]. أما كون الحكمة الداعية إلى إجراء عادته بخلق تلك الأشياء من موادها على نحو التدريج ، كخلق السموات والأرض من مادتها التي هي الماء ، بعد خصوص القدر المذكور ، والزمان المحدود ـ وهو ستة أيام ـ ؛
__________________
(٥٦) ـ النوري ، الشيخ ميرزا حسين الطبرسي : مستدرك الوسائل ، ج ١٠ / ٣٢٢ ـ ٣٢٣. (باب ٥١ ـ إستحباب التبرك بكربلاء ـ حديث ٣).
فهو من أسرار القضاء والقدر التي لا يمكن أن يحيط بها عقل البشر ؛ ولذا ما ورد من الأعداد الموجودة في بعض الآيات والروايات ، قد يطلق ويراد بها الكثرة لا خصوص العدد ، وقد يراعى في ذلك عقول المخاطبين وأفهامهم.
ثانياً ـ إنّ التعبير بقدر وزمان معين في الآيات والروايات ؛ للتفهيم والتقريب. وذلك كتقدير الفلك بالبروج والمنازل والدرجات ، وتقدير الزمان بالسنين والشهور والأيام والساعات ، وعلى هلا لا يُعد في أنّ الحكمة الإلهية إقتضت أن تقدر للزمان المتقدم على زمان الدنيا ، بل للزمان المتأخر عن زمانها أيضاً ، بأمثال ما قدّره لزمانها من السنين إلى الساعات ، لكن مع رعاية مناسبة لهذا الإجراء إلى المقدّر بها ، فكما أنّ المناسب لزمان الدنيا أن يكون كل يوم منه بقدر دورش للشمس ، فكذلك يجوز أن يكون المناسب للزمان المتقدم ، أن يكون لكل يوم منه بألف سنة من أيام الدنيا ، كما جاء في قوله تعالى : ( وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ) [الحج / ٤٧] ، وفي قوله تعالى : ( فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ) [المعارج / ٤]. فيكون المناسب للزمان المتقدم أن يكون كل يوم منه بمقدار ألف سنة من زمان الدنيا ، وللزمان المتأخر مساوياً لخمسين ألف سنة منه ، ويؤيد ذلك ما ذكر في الروايات التالية :
١ ـ عن أبي جعفر عليه السلام في حديث طويل وفيه قال : (إذا قام عليه السلام سار إلى الكوفة فهدم أربعة مساجد ـ إلى أن قال : ـ فمكث على ذلك سبع سنين ، مقدار كل سنة عشر سنين من سنينكم ، ثم يفعل ما يشاء. قال : قلت : جعلت فداك فكيف تطول السنون؟ قال : يأمر الله تعالى الفلك باللبوث وقلة الحركة ، فتطول الأيام لذلك والسنون. قال له : إنهم يقولون : إن تغير فسد؟
قال : ذلك قول الزنادقة ، فأما المسلمون فلا سبيل لهم إلى ذلك ، وقد شَقّ الله القمر لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ، ورَدّ الشمس من قبله ليوشع بن نون ، وأخبر بطول يوم القيامة وأنه كألف سنة مما تعدون)(٥٧) .
٢ ـ عن أبي عبد الله عليه السلام ـ في حديث طويل قال فيه ـ : (فإن في يوم القيامة خمسين موقفاً ، كل موقف مثل ألف سنة مما تعدون ، ثم تلا هذه الآية : ( فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ) [المعارج / ١٤](٥٨) . وبعد هذا البيان لا يستبعد ما أشارت إليه الروايات من أنّه تعالى قَدّر للزمان المتقدم أسابيع ، وسَمّى الأول من أيامها بالأحد ، والثاني بالإثنين وهكذا إلى السبت ، وكذلك قَدّر له شهوراً تامة كل منها ثلاثون يوماً ، سمى أولها بالمحرم ، أو رمضان ـ على إختلاف الروايات ـ في أول شهور السنة ، وثانيها بصفر أو شوال ، وهكذا إلى ذي الحجة أو شعبان ، وعلى كل تقدير كان المجموع سنة كاملة موافقة لثلاثمائة وستين يوماً ، ثم جعل أيام أسابيعنا وشهورنا موافقة لأيام تلك الأسابيع والشهور ، في المبدأ والعِدّة والتسمية ، وقد يستشهد له بما جاء في قوله تعالى : ( إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ) [التوبة / ٣٦].
وعلى هذا لا إشكال في ما ذكرته بعض الروايات : من خلق السماء وجَنّاتها والملائكة يوم الخميس ، وخلق الأرض في يوم الأحد ، وخلق دواب البحر يوم الإثنين ، وخلق الشجر ونبات الأرض وأنهارها وما فيها من الهوام في
__________________
(٥٧) ـ المفيد ، الشيخ محمد بن محمد النعمان : الإرشاد ، ج ٢ / ٣٨٥.
(٥٨) ـ المفيد ، الشيخ محمد النعمان : الأمالي / ٢٧٤ ـ ٢٧٥ (الماجلس ٣٣ ـ حديث ١).
يوم الثلاثاء(٥٩) . وكذلك ما روي أن دحو الأرض كان في ليلة خمس وعشرين من ذي القعدة. هذا ما استفدته من بعض الأعلام(٦٠) ، وبعد بيان هذه المقدمة ؛ نذكر آراء بعض الأعلام كالتالي :
١ ـ الفيض الكاشاني :
«لعلّ المراد بالقبلية القبلية بالشّرف ، وبالأعوام الدّرجات ، فإنّ ما لأجله الشيء يكون أقدم من ذلك الشيء بالرتبة»(٦١) .
٢ ـ الشيخ أحمد آل طوق القطيفي :
«لعلّ المراد بالأعوام ـ هنا ـ غيب الأعوام المعهودة وعللها ؛ وهي رتب الوجود المتحركة على نقطة ، وهي سِنِّي الشهور الإثني عشر التي عند الله ، وسني الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض ، وذكر مثل هذه السنين متكرر في الأخبار جداً»(٦٢) .
٣ ـ السيد صادق الروحاني :
«المراد من خلق أرض كربلاء في تلكم الروايات هو الخلق في عالم الأنوار ، لا الخلق في هذا العالم ، وتكون الروايات نظير ما ورد عن خلق نور الرسول (صلى الله عليه وآله) ، والإمام أمير المؤمنين (عليه آلاف التحية والثناء) ، قبل خلق آدم بآلاف السنني ، مع أنهما في هذا العالم من أولاد آدم»(٦٣) .
__________________
(٥٩) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٥٤ / ٧١.
(٦٠) ـ نفس المصدر / ٢١٦ ـ ٢١٩. (بتصرف)
(٦١) ـ آل طوق ، الشيخ أحمد بن الشيخ صالح : رسائل آل طوق القطيفي ، ج ٣ / ٩٩.
(٦٢) ـ جواب إستفتاء خطي.
٤ ـ إستنتاج المؤلف :
بعد عرض آراء الأعلام نخرج بالنتيجة التالية :
أولاً ـ المستفاد من الروايات المصرِّحة بأنّ خلق أرض كربلاء من قبل خلق الكعبة يمكن تلخيصها فيما يلي :
أ ـ التصريح بعدد معين من الأعوام ، كما في رواية أبي الجارود ، عن الإمام زين العابدين عليه السلام قال : (إتخذ الله أرض كربلاء حرماً آمنا مباركاً قبل أن يخلق الكعبة بأربعة وعشرين ألف عام)(٦٤) . وأيضاً ما رواه عمرو بن ثابت ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : (خلق الله أرض كربلاء قبل أن يخلق أرض الكعبة بأربعة وعشرين ألف عام ، وقدّسها وبارك عليها)(٦٥) .
ب ـ عدم التصريح بعدد معين من الأعوام ، كما في رواية أبي يعفور ، عن الصادق عليه السلام قال : (إنّ الله أتخذ [بفضل قبره] كربلاء حرماً آمناً مباركاً قبل أن يتخذ مكة حرماً)(٦٦) .
ج ـ التصريح بإختيارها يوم دحور الأرض ، كما في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام : (لما سار أبو عبد الله من المدينة ؛ أنته أفواج مسلمي الجن ـ إلى أن قال ـ : قال عليه السلام لهم : فإذا أقمت في مكاني فبماذا يبتلى هذا الخلق المتعوس ، وبماذا يختبرون؟ ومن ذا يكون ساكن حفرتي بكربلاء؟ وقد إختارها الله لي يوم دحا الأرض ، وجعلها معقلاً لشيعتنا ، وتكون أماناً
__________________
(٦٤) ـ النوري ، ميرزا حسين الطبرسي : مستدرك الوسائل ، ج ١٠ / ٣٢٢ (باب ٥١ من أبواب المزار ـ حديث ٣).
(٦٥) ـ نفس المصدر / ٣٢٢ (حديث ٢).
(٦٦) ـ نفس المصدر / ٣٢٤ (حديث ٧).
لهم في الدنيا والآخرة)(٦٧) . وبعد عرض هذه الروايات ؛ نطرح السؤال التالي :
س / ما المراد بلفظة (خَلَقَ) في الروايات المتقدمة :
ج / المستفاد من كلمات الأعلام(٦٨) ما يلي :
إنّ للفظة (خلق) عدة إستعمالات وأهمها التالي :
١ ـ الإبداع : وهو إيجاد شيء من غير أصل ، ومنه قوله تعالى : ( خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ) [الأنعام / ١]. أي أبدعها بدلالة قوله تعالى : ( بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ) [البقرة / ١١٧] ، ولا يكون الخلق بهذا المعنى إلا الله تعالى ؛ ولهذا قال عَزّ وجَلّ للفصل بينه وبين عباده : ( أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ) [النحل / ١٧].
٢ ـ إيجاد شيء من شيء ، كما في قوله تعالى : ( خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ) [النساء / ١].
٣ ـ التقدير : عَبّر عنه الإمام الرضا عليه السلام في جوابه ليونس بن عبد الرحمن : (فنعلم ما القدر؟ فقال يونس : قلت لا؟ قال عليه السلام هي الهندسة ووضع الحدود من ا لبقاء والفناء)(٦٩) . وعَرّفه الشيخ الطريحي (قده) بقوله : «ومعنى خلق التقدير : نقوش في اللوح المحفوظ»(٧٠) ، أي علوم غيبية.
٤ ـ التكوين : وجودات خارجية ؛ من سماء وأرض وبشر وملائكة وحيوانات ونحو ذلك.
__________________
(٦٧) ـ المصدر السابق / ٣٢٥ (حديث ٧).
(٦٨) ـ راجع البحار ٩١ / ٢٥٠ ، والمفردات في غريب القرآن ج ١ / ٢٠٩.
(٦٩) ـ الكليني ، الشيخ محمد بن يعقوب : الأصول من الكافي ، ج ١ / ١٥٨.
(٧٠) ـ الطريحي ، الشيخ فخر الدين : مجمع البحرين ج ٥ / ١٥٩.
وبعد معرفة هذه الإستعمالات للفظة (خَلَقَ) ؛ يظهر معنى الرواية التي عليها مدار البحث في التقدير ، والأعوام الغيبية المعلومة عند الله عَزّ وجَلّ ، ويتفق هذا الوجه مع ما ذهب إليه الشيخ أحمد آل طوق القطيفي. كما يظهر معنى الرواية القائلة : (وقد إختارها الله تعالى لي يوم دعا الأرض) في الخلق التكويني.
ثانياً ـ جاء في رواية بَيّاع السابري ، عن الإمام الصادق عليه السلام قال : (إنّ أرض مكة قالت : من مثلي؟ وقد جعل بيت الله على ظهري ، يأتيني الناس من كل فَجّ عميق ، وجعلت حرم الله وأمنه. فأوحى الله إليها : أن كُفّي وقرِّي فوعزتي ما فَضْلٌ فُضّلتِ به فيما أعطيت كربلاء ، إلا بمنزلة أبرة غمست في البحر فحملت من ماء البحر ، ولولا تربة كربلاء ما فًضّلتِ ، ولولا من تضمنت أرض كربلاء ما خلقتك ، ولا خلقت البيت الذي به إفتخرتِ)(٧١) .
نستفيد من هذه الرواية ، أنّ أرض مكة تفتخر بالبيت الحرام ، الذي هو أول بيت وضع للعبادة ، وجعله الله سبحانه وتعالى هدىً للعالمين ، كما في قوله تعالى : ( إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ) [آل عمران / ٩٦]. ولكن كربلاء تفتخر بالحسين عليه السلام ، كما في حديث الإمام السجاد عليه السلام : (أنا أرض الله المقدّسة ، والطينة المباركة ، التي تضمنت سيد الشهداء) ، وسيد الشهداء عليه السلام أفضل من الكعبة والبيت الحرام ؛ لأنّه عليه السلام من أهل بيت آل محمد عليهم السلام ، الذين هم أول بيت وضع للمخلوقات من الأنبياء والأوصياء والملائكة ، ويمكن الإستشهاد لذلك بما يلي :
__________________
(٧١) ـ النوري ، ميرزا حسين الطبرسي : مستدرك الوسائل ، ج ١٠ / ٣٢٢ (باب ٥١ من أبواب المزار ـ حديث ١).
أ ـ ما جاء في حديث الإمام الصادق عليه السلام : (نحن شجرة النبوة ، ومعدن الرسالة ، ونحن عهد الله ، ونحن ذمّة الله ، لم نزل أنواراً حول العرش نسبِّح ، فيسبِّح أهل السماء لتسبيحنا ، فلما أنزلنا إلى الأرض ؛ سَبّحنا فسبّح أهل الأرض ، فكل علم خرج إلى السماوات والأرض فمنّا وعَنّا ، وكان في قضاء الله السابق أن لا يدخل النار محبّ لنا ، ولا يدخل الجنة مبغض لنا ؛ لأنّ الله يسأل العباد يوم القيامة عَمّا عهد إليهم ، ولا يسأل عَمّا قضى عليهم)(٧٢) .
ب ـ ما جاء في حديث الراهب اليماني مع الإمام الكاظم عليه السلام : (فقال له أبو إبراهيم عليه السلام : عد إلى حديث الهندي. فقال له الراهب : سمعت بهذه الأسماء ولا أدري ما بطائنها ولا شرائحها ، ولا أدري ما هي ، ولا كيف هي ، ولا بدعائها فانطلقت حتى قدمت سندان الهند ، فسألت عن الرجل فقيل لي : إنه بنى ديراً في جبل فصار لا يخرج ولا يرى إلا في كل سنة مرتين ، وزعمت الهند أنّ الله تعالى فَجّر له عيناً فيديره ، وزعمت الهند أنه يُزرع له من غير زرع يلقيه ، ويحدث له من غير حدث يعمله ؛ فإنتهيت إلى بابه ، فأقمت ثلاثاً لا أدقّ الباب ، ولا أعالج الباب ، فلما كان اليوم الرابع فتح الله الباب. ـ إلى أن قال : ـ فقلت له : اُخبرت أنّ عندك إسماً من أسماء الله تعالى تبلغ به في كل يوم وليلة بيت المقدس وترجع إلى بيتك ، فقال لي : فهل تعرف البيت المقدس الذي بالشام. فقال : ليس بيت المقدس ، ولكنه البيت المقدّس ؛ وهو بيت آل محمد. فقلت له : أما ما سمعت به إلى يومي هذا ، فهو بيت المقْدِس! فقال لي : تلك محاريب الأنبياء ، وإنما كان يقال لها : حظيرة المحاريب ، حتى جاءت الفترة التي كانت بين محمد وعيسى صلى الله عليهما ، وقرب البلاء من
__________________
(٧٢) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٢٥ / ٢٤.
أهل الشرك ، وحَلّت النقمات في دور الشياطين ، وجَلَت النغمات ـ أي إرتفعت الأصوات التي كانت ساكنة في دور الشياطين ، وهي البدع الباطلة في مدارس ومجالس أهل الضلالة ـ ، فحولوا وبدلوا ، ونقلوا تلك الأسماء ؛ وهو قول الله تبارك وتعالى : ( إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ) (٧٣) ، فالبطن آل محمد ، والظهر مَثل)(٧٤) .
ذكر الشيخ محمد صالح المازندراني (قده) : «وقوله : البطن لآل محمد الظهر مثل ، إشارة إلى أنّ للآية ظاهراً وباطناً ، الظاهر بيان لما فعله المشركون من تبديل إسم الإله ونقله عن موضعه ، وهو الله جَلّ شأنه إلى الأصنام ـ حتى سموها آلهة ، والباطن بيان لما فعله الجاهلون من تبديل اسم البيت المقَدّس ونقله عن موضعه وهو بيت آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى البيت الذي في الشام ؛ وهو حظيرة المحاريب ، والله أعلم»(٧٥) . وبعد هذا البيان ؛ تبين لنا أنّ الأصل هو بيت آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم لتطهره عن النقائص والعيوب ، وتنزهه عن الرذايل والذنوب ، وهو ما ذكره الباري عَزّ وجَلّ : ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ) [الأحزاب / ٣٣]. وبعد هذا البيان ؛ نخرج بالنتيجة التالية :
إنّ الدرجات التي بَشّر بها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم سبطه سيد الشهداء في الجنان : (وإنّ لك في الجنان لدرجات لا تنالها إلا بالشهادة)(٧٦) وكذلك
__________________
(٧٣) ـ النجم / ٢٣.
(٧٤) ـ القمي ، الشيخ عباس : منتهى الآمال ، ج ٢ / ٢٥٣.
(٧٥) ـ المازندراني ، الشيخ محمد صالح : شرح أصول الكافي ، ج ٧ / ٢٦٨.
(٧٦) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٢٥ / ٢٤.
التصريح بكون كربلاء هي مسكن أوليائه وأولي العزم من الرسل في الجنة ، كما في حديث الباقر عليه السلام : (فما زالت قبل خلق الله الخلق مقدسة مباركة ، لا تزال كذلك حتى يجعلها الله أفضل مسكن في الجنة ، وأفضل منزل ومسكن يسكن الله فيه أولياءه في ال جنة) ، وكذلك ما جاء في حديث السجاد عليه السلام : (وأنها إذا بدّل الله الأرضين رفعها كما هي برمتها نورانية صافية ، فجعلت في أفضل روضة من رياض ال جنة ، وأفضل مسكن في الجنة لا يسكنها إلا النبيون والمرسلون ـ أو قال : أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ـ ، وأنها لتزهر من رياض الجنة ، كما يزهر الكوكب الذرّي لأهل الأرض) كل تلك الأمور تفيدنا بأنّ كربلاء أفضل من أرض الكعبة بدرجات في عالم الدنيا والآخرة ، وهذا يتفق مع ما ذهب إليه الفيض الكاشاني (قده) ، فتحقق الجمع بين الوجهين اللذين ذكرهما العلمين القطيفي والفيض الكاشاني.
وأما الوجه الثالث الذي ذكره السيد صادق الروحاني (دام ظله) ؛ فله مكان من القوة. ويمكن أن يضاف إلى هذا الوجه فائدة وهي : أنّ كربلاء المخلوقة في عالم الأنوار ترفع بنورانيتها ، وتكون مسكناً لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار عليهم السلام ، وهذه الخصوصية لكربلاء التي كانت مخلوقة في عالم الأنوار ، وفي عالم الدنيا مثوى للحسين عليه السلام وأهل بيت عليهم السلاما ، وفي الآخرة مسكناً للمقربين من الأنبياء والأوصياء ، فلم تكن تلك الخصوصيات لبقعة من البقاع الأخرى.
الثاني ـ دحو الأرض من تحت الكعبة :
س / كيف نجمع بين كون كربلاء أفضل من أرض الكعبة ، وبين ما دلّ على أن الكعبة أفضل بقاع الأرض باعتبار دحو الأرض من تحتها؟
ج / يمكن الإجابة على هذا السؤال كالتالي :
يستفاد من كلمات الشيخ أحمد آل طوق (قده) : «إنّ الكعبة بالنسبة إلى الأرض كالقلب الصنوبري لجسد الإنسان ، فهو أول كائن بمعناه العقلي والحسي بارز من الإيمان ، ثم يُبنى عليه الجسد كما هو الحق ، وهو المشهور بين أهل الشتريح ، فكذلك الكعبة ، فهي أول كائن من الأرض ، ثم دحيت الأرض من تحتها على مثال دحو جسد الإنسان من تحت قلبه ، فهي أشرف بقعة من الأرض باعتبار الجسدانية ، وإن كانت كربلاء أفضل بمقام آخر»(٧٧) .
أقول : كون الأرض دحيت من تحت الكعبة لا يدل على أفضلية أرض الكعبة على كربلاء ، فإنّ الأسبقية في الوجود الخارجي لا يدل على الأفضلية في الرتبة والشرف ، فالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار عليهم السلام أفضل المخلوقات على الإطلاق ، ومع هذا يلاحظ أنّ الأنبياء عليهم السلام وُجدوا على الأرض قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله الكرام عليهم السلام ، بل يمكن القول بأنّ دحو الكعبة من باب المقدمة لأرض كربلاء وبقية بقاع أهل البيت عليهم السلام ، ويؤيد ذلك ما جاء في حديث بيّاع السابري عن الإمام الصادق عليه السلام : (ولولا تربة كربلاء ما فُضلّتِ ، ولولا مَن تضمنت أرض كربلاء ما خلقتك ، ولا خلقت الذي به إفتخرت).
وأما خصوص دحو الأرض من تحت الكعبة دون غيرها ؛ فهذا راجع إلى الحكمة والمصالح الإلهية لعباده.
٢ ـ أطهر بقاع الأرض :
ورد هذا الإسم في الحديث التالي :
__________________
(٧٧) ـ آل طوق : الشيخ أحمد بن الشيخ صالح : رسائل آل طوق القطيفي ، ج ٣ / ٢٨٦ ، ٣١٩ (بتصرف).
ـ عن قدامة بن زائدة ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) ، عن عمته زينب ، عن أم أيمن ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ـ في حديث طويل ـ أنّه قال : (قال جبرائيل : وإنّ سبطك هذا ـ وأومأ بيده إلى الحسين عليه السلام ـ مقتول في عصابة من ذريتك وأهل بيتك وأخيار من أمتك ، بضفة الفرات بأرض تدعى كربلاء ، ومن أجلها يكثر الكرب والبلاء على أعدائك وأعداء ذريتك ، في اليوم الذي لا ينقضي حسرته ، وهي أطهر بقاع الأرض وأعظمها حرمة ، وإنّها لمن بطحاء الجنة )(٧٨) .
٣ ـ أكرم أرض الله :
ورد هذا الإسم في الحديث التالي :
عن أبي جعفر عليه السلام قال : (الغاضرية هي البقعة التي كَلّم الله فيها موسى بن عمران ، وناجى نوحاً فيها ، وهي أكرم أرض الله عليه ، ولولا ذلك ما استودع الله فيها أولياءه وأنبياءه ، فزوروا قبورنا بالغاضرية )(٧٩) .
٤ ـ البقعة الطيّبة :
«البُقْعَة : قطعة من الأرض على غير هيئة التي بجنبها ، والجمع بُقَعْ وبِقَاع»(٨٠) .
وقد ذكرت بعض الروايات هذا الإسم كالتالي :
وروي : إذا أخذته فقل : (اللهم بحق هذه التربة الطاهرة ، وبحق البقعة الطيبة ، وبحق الوصي الذي توارية ، وبحث جَدّه وأبيه ، وأمه وأخيه ، والملائكة
__________________
(٧٨) ـ النوري ، ميرزا حسين الطبرسي : مستدرك الوسائل ، ج ١٠ / ٣٢٥ (باب ٥١ من أبواب المزار ـ حديث ٩).
(٧٩) ـ نفس المصدر / ٣٢٤ (حديث ٥).
(٨٠) ـ ابن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم : لسان العرب ، ج ٨ / ١٨.
الذين يحفون به ، والملائكة العكوف على قبر وليك ، ينتظرون نصره صلى الله عليهم أجمعين ، إجعل فيه شفاء من كل داء ، وأماناً من كل خوف ، وغنىً من كل فقر ، وعِزّا من كل ذلّ ، وأوسع به عليّ في رزقي ، وأصحّ به جسمي)(٨١) .
وأوردها الشيخ المجلسي (قده) هكذا : (وروي إذا أخذته فقل : بسم الله ، اللهمَّ بحق هذه التربة الطاهرة ، وبحق البقعة [المباركة] الطيبة)(٨٢) .
٥ ـ بُقْعةٌ كثيرةُ الخير :
نَصّ على هذا الإسم الحديث التالي :
عن خالد الرٍّبعي قال : حدثني من سمع كعباً يقول : (أوّل من لعن قاتل الحسين بن علي عليه السلام إبراهيم خليل الرحمن ، وأمر ولده بذلك وأخذ عليهم العهد والميثاق ، ثم لعنه موسى بن عمران وأمر أمته بذلك ، ثم لعنه داود وأمر بني إسرائيل بذلك ، ثم لعنه عيسى وأكثر أن قال : يا بني إسرائيل إلعنوا قاتله ، وإن أدركتم أيامه فلا تجلسوا عنه ، فإنّ الشهيد معه كالشهيد مع الأنبياء مقبل غير مدبر ، وكأني أنظر إلى بقعته ، وما من نبي إلا وقد زار كربلاء ووقف عليها ، وقال : إنك لبقعة كثيرة الخير ، فيك يدفن القمر الأزهر)(٨٣) .
٦ ـ البقعة المباركة :
نَصّت الروايات على هذا الإسم نذكر منها التالي :
١ ـ عن مخرمة بن ربعي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : (شاطئ الوادي الأيمن الذي ذكره الله تعالى في القرآن ؛ هو الفرات ، والبقعة المباركة هي كربلاء)(٨٤) .
__________________
(٨١) ـ ابن قولويه ، الشيخ جعفر بن محمد : كامل الزيارات / ٤٧٢ (الباب ٩٣ ـ من أين يؤخذ طين الحسين ـ حديث).
(٨٢) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٩٨ / ١٢٨.
(٨٣) ـ نفس المصدر ، ج ٤٤ / ٣٠١.
(٨٤) ـ الطوسي ، الشيخ محمد بن الحسن : تهذيب الأحكام ، ج ٦ / ٣٨.
٢ ـ وفي لفظ آخر هكذا : عن عرفة ، عن ربعي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : (شاطئ الوادي الأيمن الذي ذكره الله تعالى في كتابه هو الفرات ، والبقعة المباركة هي كربلاء ، والشجرة هي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ...)(٨٥) .
قال الشيخ المجلسي (قده) : «لعلّ المراد أنّ بتوسط روح محمد صلى الله عليه وآله وسلم أوحى الله ما أوحى في هذا المكان ، وتشبيهه بالشجرة لتفرغ أغصان الإمام منه ، واجتناء ثمرات العلوم منهم إلى آخر الدهر ، كما ورد في تفسير قوله تعالى : ( مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ) (٨٦) ...»(٨٧) .
٧ ـ بطحاء الجنّة :
«البطحاء : مسيل فيه دقاق الحصى والتراب اللين مما جَرّته السيول ، والجمع بطحاوات وبطاح»(٨٨) .
__________________
(٨٥) ـ ابن قولويه ، الشيخ جعفر بن محمد : كامل الزيارات / ١٩ (الباب ١٣ ـ فضل الفرات وشربه والغسل فيه ـ حديث ١٠). وبعد ذكر هذين الحديثين نستنتج ما يلي :
١ ـ الإختلاف الوارد في السند هكذا : في التهذيب : «عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن الحكم ، عن مخرمة بن ربعي». وفي كامل الزيارات هكذا : «عن الحسن بن سعيد ، عن علي بن الحكم ، عن عرفة ، عن ربعي».
٢ ـ الإختلاف الوارد في المتن هكذا : في التهذيب و... في القرآن هو الفرات. وفي كامل الزيارات : «في كتابه هو الفرات «و» الشجرة هي محمد ...» هذه الزيادة غير موجودة في التهذيب ، فالنتيجة التي توصلنا إليها هي التالي :
أولاً ـ إن الصحيح هو الحسين بن سعيد ، لا الحسن بن سعيد ؛ حيث أنه يروي عن علي بن الحكم ـ كما أشار إليه الفقيه المحقق السيد الخوئي (قده) في المعجم ج ٤ / ٣٤٨.
ثانياً ـ إنّ عرفة بن بريد (يزيد) من أصحاب الصادق (ع) وروى عن ربعي بن عبد الله ، وروى عنه علي بن الحكم ، كما في المعجم ، ج ١١ / ١٣٧ ، وج ٧ / ١٦.
ثالثاً ـ إن مخرمة بن ربعي روى عن أبي عبد الله ، وروى عنه علي بن الحكم ـ كما في المعجم / ج ١٨ / ١٠٥ ـ ، فعلى هذا يكون حديثان لا حديثاً واحداً.
(٨٦) ـ إبراهيم / ٢٤.
(٨٧) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٩٧ ٢٢٩.
(٨٨) ـ ابن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم : لسان العرب ، ج ٢ ، ٤١٢ ـ ٤١٣ (بتصرف).
وقد ذكر هذا الإسم في الحديث التالي :
في حديث الإمام زين العابدين عليه السلام : (قال جبرائيل : وإنّ سبطك هذا ـ وأومأ بيده إلى الحسين عليه السلام ـ مقتول في عصابة من ذريتك ، وأهل بيتك ، وأخيار من امتك ، بضفة الفرات ، بأرض تدعى كربلاء ، من أجلها يكثر الكرب والبلاء على أعدائك ، وأعداء ذريتك ، في اليوم الذي لا ينقضي كربه ، ولا تنقضي حسرته ، وهي أطهر بقاع الأرض وأعظمها حرمة ، وإنها لمن بطحاء الجنّة)(٨٩) .
__________________
(٨٩) ـ النوري ، ميرزا حسين الطبرسي : مستدرك الوسائل ، ج ١٠ / ٣٢٥ (باب ٥١ من أبواب المزار ـ حديث ٩).
٨ ـ تربة الحسين عليه السلام
٩ ـ التربة الطاهرة
١٠ ـ تربة الفرخ المبارك
١١ ـ تربة قبر الحسين عليه السلام
١٢ ـ تربة كربلاء
١٣ ـ التربة المباركة
١٤ ـ تربة المظلوم
١٥ ـ ترعة من ترع الجنة
٨ ـ تربة الحسين (عليه السلام) :
نَصّت بعض الروايات على هذا الإسم كالتالي :
١ ـ عن ا لحسين بن أبي العلا قال : سمعت أبا عبد الله يقول : (حَنِّكوا أولادكم بتربة الحسين عليه السلام فإنّها أمان)(٩٠) .
٢ ـ عن ابن عباس ، قال : (الملك الذي جاء إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم يخبره بقتل الحسين عليه السلام كان جبرئيل عليه السلام الروح الأمين ، منشور الأجنحة باكياً صارخاً ، قد حمل من تربة الحسين عليه السلام ، وهي تفوح كالمسك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : وتفلح أمتي تقتل فرخي ، أو فرخ ابنتي؟! فقال جبرئيل : يضربها الله بالإختلاف فتختلف قلوبهم)(٩١) .
٣ ـ عن المسيّب بن زهير قال : قال لي موسى بن جعفر عليه السلام بعد ما سُمّ : (لا تأخذوا من تربتي شيئاً لتتبركوا به ، فإنّ كل تربة لنا محرمة إلا تربة جدي الحسين بن علي عليه السلام ، فإنّ الله عَزّ وجَلّ جعلها شفاء لشيعتنا وأوليائنا)(٩٢) .
٤ ـ عن زيد بن أسامة قال : كنت في جماعة من عصابتنا بحضرة سيدنا الصادق عليه السلام ، فأقبل علينا أبو عبد الله عليه السلام فقال : (إنّ الله جعل تربة جدي الحسين عليه السلام شفاء من كل داء ، وأماناً من كل خوف ، فإذا تناولها أحدكم فليقبلها ويضعها على عينيه ، وليمرها على سائر جسده ...)(٩٣) .
٥ ـ روي أنّ رجلاً سأل الصادق عليه السلام فقال : (إني سمعتك تقول : إنّ تربة الحسين عليه السلام من الأدوية المفردة ، وإنّها لا تمر بداء إلا هضمته. فقال : قد
__________________
(٩٠) ـ الطوسي ، الشيخ محمد بن الحسن : تهذيب الأحكام ، ج ٦ / ٧٤.
(٩١) ـ بن قولويه ، الشيخ جعفر بن محمد : كامل الزيارات / ١٣١.
(٩٢) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٩٨ / ١١٨.
(٩٣) ـ نفس المصدر : ١١٩.
كان ذلك ، أو قلت ذلك ، فما بالك؟ قال : إني تناولتها فما إنتفعت ، قال عليه السلام : أما إنّ لها دعاء ، فمن تناولها ولم يدع به لم يكد ينتفع بها. فقال له : ما أقول إذا تناولتها؟ قال : تقبلها قبل كل شيء وتضعها على عينيك ، ولا تناول منها أكثر من حمّصة ، فإنّ من تناول منها أكثر من ذلك ، فكأنما أكل من لحومنا ودمائنا ، فإذا تناولت فقل : اللهمّ إني أسألك بحقِّ الملك الذي قبضها ، وأسألك بحق النبي الذي خزنها ، وأسألك بحق الوصي الذي حلّ فيها ، أن تصلِّي على محمد وآل محمد ، وأن تجعله شفاء من كل داء ، وأماناً من كل خوف ، وحفظاً من كل سوء ، فإن قلت ذلك فاشددها في شيء وأقرأ عليها سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر ، فإنّ الدعاء الذي تقدم لأخذها هو الإستيذان عليها ، وقراءة إنا أنزلناه ختمها)(٩٤) .
٦ ـ عن معاوية بن عَمّار قال : (كان لأبي عبد الله عليه السلام خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله ، فكان إذا حضرت الصلاة صَبّه على سجادته وسجد عليه ، ثم قال عليه السلام : السجود على تربة الحسين عليه السلام يخرق الحجب السّبع) (٩٥). قال الشيخ المجلسي (قده) : «خرق الحجب كناية عن قبول الصلاة ، ورفعها إلى السماء»(٩٦) .
٩ ـ التربة الطاهرة :
ذكر هذا الإسم في الرواية التالية :
وروي إذا أخذته فقل : (بِسْمِ اللهِ ؛ اللّهمّ بحقِّ هذه التربة الطاهرة ، وبحقّ البقعة [المباركة] الطيبة ، وبحق الوصي الذي تواريه ، وبحقّ جدّه وأبيه ، وأمه
__________________ ـ
(٩٤) ـ المصدر السابق : ١٣٥.
(٩٥) ـ نفس المصدر : ١٣٥.
(٩٦) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ٨٢ / ١٥٣.
وأخيه ، والملائكة الذين يحفون به ، والملائكة العكوف على قبر وليك ينتظرون نصره صلى الله عليهم أجمعين ، إجعل لي فيه شفاء من كلِّ داء ، وأماناً من كل خوف ، وغنى من كلِّ ذل ، وأوسع به عليّ في رزقي ، وأصحّ به جسمي)(٩٧) .
١٠ ـ تربة الفرخ المبارك :
ذكر هذا الإسم في الرواية التالية :
عن ابن عباس ـ في حديث طويل ـ ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال فيه : (... أتعلم يا بن عباس ما هذه الأبعار؟ هذه قد شمها عيسى بن مريم عليه السلام ، وذلك أنه مر بها ومعه الحواريون ، فرأى هيهنا الظباء مجتمعة وهي تبكي ، فجلس عيسى عليه السلام وجلس الحواريون معه ، فبكى وبكى الحواريون وهم لا يدرون لِمَ جلس ولِمَ بكى! فقالوا يا روح الله وكلمته ما يبكيك؟ قال : أتعلمون أي أرض هذه؟ قالوا : لا ، قال : هذه أرض يقتل فيها فرخ الرسول أحمد ، وفرخ الحرة الطاهرة البتول شبيهة أمي ، ويلحد فيها ، طينة أطيب من المسك ؛ لأنها طينة الفرخ المستشهد ، وهكذا تكن طيبنة الأنبياء وأولاد الأنبياء ، فهذه الظباء تكلمني وتقول : إنها ترعى في هذه شوقاً إلى تربة الفرخ المبارك ، وزعمت أنها آمنة في هذه الأرض)(٩٨) .
١١ ـ تربة قبر الحسين :
من الروايات التي نَصّت على هذا الإسم الرواية التالية :
عن بعض أصحابنا ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، قال : (إني رجل كثير العلل والأمراض ، وما تركت دواء إلا تداويت به. فقال لي : فأين أنت عن تربة قبر الحسين عليه السلام ، فإنّ فيها الشفاء من كل داء ، والأمن من كل خوف ...)(٩٩) .
__________________
(٩٧) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ٩٨ / ١٢٨.
(٩٨) ـ الصدوق ، الشيخ محمد بن علي بن بابويه : آمالي الاصدوق / ٤٧٩ (المجلس ٨٧ ـ حديث ٥).
(٩٩) ـ ابن قولويه ، الشيخ جعفر بن محمد : كامل الزيارات / ٤٧٣ (باب ٩٣ ـ حديث ١٠).
١٢ ـ تربة كربلاء :
نصّت على هذا الإسم الروايات التالية :
١ ـ عن أبي خديجة ـ سالم بن مكرم الحمال ـ ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : (لما ولدت فاطمة الحسين عليهما السلام ، جاء جبرئيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له : إنّ أمتك تقتل الحسين عليه السلام من بعدك ، ثم قال : ألا أريك من تربته ، فضرب بجناحه فأخرج من تربة كربلاء وأداها إياه ، ثم قال هذه التربة التي يقتل عليها)(١٠٠) .
٢ ـ عن عمر بن يزيد بياع السابري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (إنّ أرض الكعبة قالت : من مثلي وقد بنى بيت الله على ظهري ، ويأتيني الناس من كل فج عميق ، وجعلت حرم الله وأمنه ، فأوحى الله إليها أن كفّي وقرّي ، فواعزتي وجلالي ، ما فَضْلُ ما فُضّلت به فيما أعطيت أرض كربلاء إلا بمنزلة الإبرة غمست في البحر ، فحملت من ماء البحر ، ولولا تربة كربلاء ما فضلتك ، ولولا من ضمته كربلاء لما خلقتك ، ولا خلقت الذي إفتخرت به ...)(١٠١) .
١٣ ـ التربة المباركة :
ذكر هذا الإسم في الروايات التالية :
١ ـ عن أبي حمزة الثمالي ، قال : قال الصادق عليه السلام : (... وتقول : اللّهُمَّ رَبِّ هذه التربة المباركة الميمونة ، والملك الذي هبط بها ، والوصيِّ الذي هو فيها ، صَلِّ على محمد وآل محمد وسَلّم ، وأنفعني بها ، إنك على كل شيء قدير)(١٠٢) .
__________________
(١٠٠) ـ المصدر السابق / ١٣٠ ـ ١٣١ (باب ١٧ ـ حديث ٦).
(١٠١) ـ الحر العاملي ، الشيخ محمد بن الحسن : وسائل الشيعة ، ج ١٤ / ٥١٤ ـ ٥١٥ (باب ٦٨ من أبواب المزار ـ حديث ٢).
(١٠٢) ـ ابن قولويه ، الشيخ جعفر بن محمد : كامل الزيارات / ٤٧٥ ـ ٤٧٦ ، (باب ٩٣ ـ حديث ١٢).
٢ ـ عن حَنّان بن سدير عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : (من أكل من طين قبر الحسين عليه السلام غير مستشف به ؛ فكأنما أكل من لحومنا ، فإذا احتاج أحدكم إلى الأكل منه ليستشفي به ؛ فليقل : بسم الله وبالله ، اللهم رَبِّ هذه التربة المباركة الطاهرة ، وربّ النور الذي أنزل فيه ، وربّ الجسد الذي سكن فيه ، وربّ الملائكة الموكلين به ، إجعله لي شفاء من داء كذا وكذا ، واجرع من الماء خلفه ، وقل : اللهم اجعله رزقاً واسعاً ، وعلماً نافعاً ، وشفاء من كل داء وسقم ، فإنّ الله تعالى يدفع بها كلّ ما تجد من السقم والهمّ والغمّ إن شاء الله)(١٠٣) .
١٤ ـ تربة المظلوم :
عن مالك بن عطية ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (إذا أخذت من تربة المظلوم ووضعتها في فيك فقل : اللّهم إنّي أسألك بحق هذه التربة ، وبحق الملك الذي قبضها ، والنبيّ الذي حضنها ، والإمام الذي حلّ فيها ، أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تجعل لي فيه شفاء نافعاً ، ورزقاً واسعاً ، وأماناً من كلّ خوف وداء ، فإنّه إذا قال ذلك ، وهب الله له العافية وشفاء)(١٠٤) .
١٥ ـ ترعة من ترع الجنة :
عن إسحاق بن عَمّار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : (موضع قبر الحسن بن علي (عليهما السلام) ، منذ يوم دفن روضة من رياض الجنة ، وقال (عليه السلام) : موضع قبر الحسين (عليه السلام) ترعة من ترع الجنة)(١٠٥) .
__________________
(١٠٣) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٩٨ / ٣٤٢.
(١٠٤) ـ النوري ، ميرزا حسين الطبرسي : مستدرك الوسائل ، ج ١٠ / ٣٤٢ (باب ٥٦ من أبواب المزار ـ حديث ٨).
(١٠٥) ـ نفس المصدر ، ج ١٠ / ٣٢٤ ـ ٣٢٥.
س / ما المراد بالترعة؟
ج / ورد في تفسير الترعة أربعة أقوال :
أحدها ـ أن يكون إسماً للدرجة ، فالمراد أنّ موضع قبره الشريف يكون في درجات الجنة ؛ لأنّ الجنة مقسمة على درجات ـ وهي منازل أهل الجنة ـ وإلى هذا يشير قوله تعالى : ( لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ ) (١٠٦) . أي ذو طبقات عند الله في الفضيلة. وقوله تعالى : ( وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ) (١٠٧) أي ولكل عامل بطاعة أو معصية درجات مما عملوا ؛ أي مراتب في عمله على حسب ما يستحقه ، فيجازى به إن خيراً فخير وإن شراً فشر. فقال المفسر : «وإنما سميت درجات لتفاضلها كتفاضل الدرج ، في الإرتفاع والإنحطاط ، وإنما يعبر عن تفاضل أهل الجنة بالدرج وعن تفاضل أهل النار بالدرك ، إلا أنّه لما جمع بينهم ، عَبّر عن تفاضلهم بالجرج تغليباً لصفة أهل الجنة»(١٠٨) . ويؤيد هذا القول ما يلي :
١ ـ عن أبي الجارود قال : قال علي بن الحسين عليه السلام (إتخذ الله أرض كربلاء حرماً آمناً مباركاً قبل أن يخلق الله أرض الكعبة بأربعة وعشرين ألف عام ، وأنها إذا بدّل الله الأرضين رفعها كما هي برمتها نورانية صافية ، فجعلت في أفضل روضة من رياض الجنة ، وأفضل مسكن في الجنة ، لا يسكنها إلا ال نبيون والمرسلون ـ أو قال أولوا العزم من الرسل ـ وأنها لتزهر من رياض الجنة ، كما
__________________
(١٠٦) ـ الأنفال / ٤.
(١٠٧) ـ الأنعام / ١٣٢.
(١٠٨) ـ الطريحي ، الشيخ فخر الدين : مجمع البحرين ، ج ٢ / ٢٩٨.
يزهر الكوكب الدري لأهل الأرض ، يغشى نورها أبصار أهل الجنة جميعاً الخ)(١٠٩) .
ثانيها ـ أن يكون إسماً للروضة على المكان العالي خاصة ، ويدل على ذلك ما تقدم في حديث أبي الجارود.
ثالثها ـ أن يكون إسما للباب ؛ أي أن هذا الحديث ورد للترغيب في العمل في هذا المجل الشريف ، ليقضي بصاحبه إلى أن يهدى إلى الجنة ، ويكون دالاً عليها ؛ لأنّ السامع لما يتلى عليه كأنه يطلع إلى الجنة ، فينظر إلى بهجتها وإلى ما أعد الله المؤمنين فيها من النعيم ، ويؤيد هذا ما يلي :
١ ـ عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر عليه السلام سمعت يقول : (من أراد أن يعلم أنّه من أهل الجنة ، فليعرض حبنا على قلبه ، فإن قَبِلَهُ قهو مؤمن ، ومن كان لنا محباً فليرغب في زيارة قبر الحسين عليه السلام ، فمن كان للحسين عليه السلام زَوّاراً كان ناقص الإيمان)(١١٠) .
٢ ـ عن زيد الشحّام قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : (من أتى قبر الحسين تَشوّقاً إليه ؛ كتبه الله من الآمنين يوم القيامة ، وأعطي كتابه بيمينه ، وكان تحت لواء الحسين بن علي عليه السلام ، حتى يدخل الجنة فيسكنه في درجته ، إنّ الله عزيز حكيم)(١١١) .
__________________
(١٠٩) ـ النوري ، ميرزا حسين الطبرسي : مستدرك الوسائل / د ١٠ / ٣٢٢ ـ ٣٢٣.
(١١٠) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٩٨ / ٤.
(١١١) ـ نفس المصدر : ٢٦.
رابعاً ـ الترعة : مسيل الماء إلى الروضة ، وإن كان هذا المعنى قريباً من الوجوه السابقة ، إلا أنّ هنا نكتة لطيفة ، وهي : إنّ في الكلام إستعارة تمثيلية ؛ حيث أن مسيل دماء الشهداء على هذه البقعة الطاهرة ، هي طريق إلى رياض الجنة ، بل بَشّرهم سيد الشهداء وأراهم منازلهم في الجنة قبل إستشهادهم ، كما ورد في الروايات الآتية :
١ ـ ذكر السيد المقرم في كتابه «مقتل الحسين» : «ولما فرغ من الصلاة قال لأصحابه : يا كرام هذه الجنة قد فتحت أبوابها ، وإتصلت أنهارها ، وأينعت ثمارها ، وهذا رسول الله والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله ، يتوقعون قدومكم ، ويتباشرون بكم ، فحاموا عن دين الله ودين نبيه ، وذبوا عن حرم الرسول. فقالوا : نفوسنا لنفسك الفداء ، ودماؤنا لدمك الوقاء ، فوالله لا يصل إليك وإلى حرمك سوء ، وفينا عرق يضرب»(١١٢) .
٢ ـ عن ابن عمارة ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله قال : (قلت له : أخبرني عن أصحاب الحسين وإقدامهم على الموت ، فقال : إنهم كشف لهم الغطاء حتى رأوا منازلهم من الجنة ، فكان الرجل منهم يقدم على القتل ليبادر إلى حوراء يعانقها ، وإلى مكانه في الجنة)(١١٣) .
٣ ـ عن أبي جعفر الثاني ، عن آبائه عليهم السلام قال : (قال علي بن الحسين عليه السلام : لما إشتدّ الأمر ؛ تغيّرت ألوانهم ، وإرتعدت فرائصهم ، ووجلت قلوبهم ، وكان الحسين عليه السلام وبعض من معه من خصائصه ، تشرق ألوانهم وتهدئ جوارحهم ، وتسكن نفوسهم ، فقال بعضهم لبعض : أنظروا لا يبالي
__________________
(١١٢) ـ المقرم ، السيد عبد الرزاق : مقتل الحسين / ٢٤٦.
(١١٣) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٤٤ / ٢٩٧.
بالموت ، فقال لهم الحسين عليه السلام : صبراً بني الكرام ، فما الموت إلا قنطرة تعبر بكم عن البؤس والضرّاء ، إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائمة ، فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر؟ ، وما هو لأعدائكم إلا كمن ينتقل من قصر إلى سجن وعذاب ، إنّ أبي حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أنّ الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر ، والموت جسر هؤلاء إلى جنانهم ، وجسر هؤلاء إلى جحيمهم ، وما كذبت ولا كذبت)(١١٤) .
٤ ـ عن الثمالي ، قال علي بن الحسين عليه السلام : (كنت مع أبي في الليلة التي قتل في صبيحتها ، فقال لأصحابه : هذا الليل فاتخذوه جنّة ، فإنّ القوم إنما يريدونني ، ولو قتلوني لم يلتفتوا إليكم ، وأنتم في حِلّ وسعة. فقالوا : والله لا يكون هذا أبداً فقال : إنكم تقتلون غداً كلكم ولا يفلت منكم رجل. قالوا : الحمد لله الذي شَرّفنا بالقتل معك.
ثم دعا فقال لهم : ارفعوا رؤسكم وانظروا ، فجعلوا ينتظرون إلى مواضعهم ومنازلهم من الجنة ، وهو يقول لهم : هذا منزلك يا فلان. فكان الرجل يستقبل الرماح والسيوف بصدره ووجهه ، ليصل إلى منزلته من الجنة)(١١٥) . هذا إستفدته من الأعلام ، والروايات ، والله العالم بحقائق الأمور.
__________________
(١١٤) ـ المصدر السابق ، ج ٤٤ / ٢٩٧.
(١١٥) ـ نفس المصدر / ٢٩٨.
١٦ ـ الحَائِر أو الحَيْر
١٧ ـ حرم الحسين
١٨ ـ رَوْضَةٌ من رِيَاضِ الجنّة
١٦ ـ الحَائِر أو الحَيْر :
هذا الإسم من أهم الأسماء التي نعتت بها البقعة الطاهرة ؛ وذلك لما أحيط به من الحرمة والتقديس ، وما ترتب على ذلك من أحكام شرعية إلى يومنا هذا ، والذي يبدو أنّ هذا الإسم كان صريحاً في بداية وضعه ، إلا أنّه حصل عليه بعض الغموض بالتدريج مع مرور الزمن ، حيث حصل في القرون المتأخرة الخلط بين الحائر والحير ، حيث يأتي مرة مترادفاً ، وأخرى مختلفاً عنه في الرواية والتاريخ ، حيث أدى هذا الخلط إلى كثير من الإلتباس في أمره ، فأشكل الأمر على الفقهاء ، وعلماء اللغة ، والتاريخ ، والذي نريد بحثه هو ما يلي :
أولاً ـ في الروايات :
١ ـ عن الحسين بن علي بن ثوير بن أبي فاخته قال : قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) : (يا حسين ، من خرج من منزله يريد زيارة الحسين بن علي بن أبي طالب ـ عليهما السلام ـ ، إن كان ماشياً كتب الله له بكل خطوة حسنة ، وحطّ بها عنه سيئة ، حتى إذا صار بالحائر كتبه من المفلحين ، وإذا قضى مناسكه ؛ كتبه الله من الفائزين ، حتى إذا أراد الإنصراف أتاه ملك فقال : أنا رسول الله ، ربك يقرئك السلام ويقول له : إستأنف العمل فقد غفر لك ما مضى)(١١٦) .
٢ ـ عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (قلت له : إذا خرجنا إلى أبيك أفلسنا في حج؟. قال : بلى. قلت : فيلزمنا ما يلزم الحاج ، قال : ماذا؟ قلت : من الأشياء التي يلزم الحاج ، قال : يلزمك حسن الصحابة لمن يصحبك ، ويلزمك قلة الكلام إلا بخير ، ويلزمك كثرة ذكر الله ، ويلزمك نظافة الثياب ،
__________________
(١١٦) ـ الفيض الكاشاني ، المولى محمد حسن : الوافي ، ج ١٤ / ١٤٦٧.
ويلزمك الغسل قبل تأتي الحائر ، ويلزمك الخشوع ، وكثرة الصلاة على محمد وآل محمد ، ويلزمك التوقير(١١٧) لأخذ ما ليس لك ، ويلزمك أن تغض بصرك ، ويلزمك أن تعود إلى أهل الحاجة من إخوانك ، إذا رأيت منقطعاً والمواساة ، ويلزمك التقية التي قوام دينك بها ، والورع عما نهيت عنه ، والخصومة وكثرة الأيمان ، والجدال الذي فيه الأيمان ، فإذا فعلت ذلك تم حجك وعمرتك ، واستوجبت من الذي طلبت ما عنده بنفقتك ، واغترابك عن أهلك ، ورغبتك فيما رغبت ، أن تنصرف بالمغفرة والرحمة والرضوان)(١١٨) .
٣ ـ عن أبي الصامت ، قال : (سمعت أبا عبد الله عليه السلام وهو يقول : من أتى قبر الحسين عليه السلام ماشياً ؛ كتب الله له بكل خطوة ألف حسنة ، ومحا عنه ألف سيئة ، ورفع له ألف درجة ، فإذا أتيت الفرات فاغتسل وعَلّق نعليك وامشِ حافياً ، وامشِ مشي العبد الذليل ، فإذا أتيت باب الحائر فكبر أربعاً ، ثم امشِ قليلاً ثم كبر أربعاً ، ثم ائت رأسه فقف عليه فكبر أربعاً وصلِّ عنده ، واسأل الله حاجتك)(١١٩) .
٤ ـ عن الحسن بن راشد ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : (من خرج من بيته يريد زيارة قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام ؛ وكّل الله به ملكاً يضع إصبعه في قفاه ، لم يزل يكتب ما يخرج من فيه حتى يرد الحائر ، فإذا دخل من باب الحائر ، وضع كفه وسط ظهره ثم قال له : أما ما مضى ؛ فقد غفر لك فاستأنف العمل)(١٢٠) .
__________________
(١١٧) ـ الظاهر (التوقي).
(١١٨) ـ بن قولويه ، الشيخ جعفر بن محمد : كامل الزيارات : ٢٥٠ ـ ٢٥١. (الباب ٨٤ ـ حديث ١).
(١١٩) ـ نفس المصدر / ٢٥٥.
(١٢٠) ـ نفس المصدر / ٣٥٢ ـ ٣٥٣.
٥ ـ عن يوسف الكناسي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (إذا أتيت قبر الحسين عليه السلام ؛ فائت الفرات واغتسل بحيال قبره ، وتوجّه إليك وعليك السكينة والوقار ، حتى تدخل الحائر من جانبه الشرقي ، وقل حين تدخله : السلام على ملائكة الله المسومين ، السلام على ملائكة الله الذين هم في هذا الحائر بإذن الله مقيمون)(١٢١) .
٦ ـ عن عامر بن جذاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (إذا أتيت الحائر فقل : الحمد لله ، وصلى الله على محمد وأهل بيته ، والسلام عليه وعليهم السلام ، ورحمة الله وبركاته ، عليك السلام يا أبا عبد الله ، لعن الله من قتلك ، ومن شارك في دمك ، ومن بلغه ذلك فرضي به ، أنا إلى الله منهم بريء)(١٢٢) .
٧ ـ عن أبي هاشم الجعفري قال : (بعث إليّ أبو الحسن (عليه السلام) في مرضه ، وإلى محمد بن حمزة ، فسبقني إليه محمد بن حمزة ، فأخبرني أنه ما زال يقول : إبعثوا إلى الحائر. فقلت لمحمد : ألا قلت له : أنا أذهب إلى الحائر ، ثم دخلت عليه فقلت : جعلت فداك أنا أذهب إلى الحائر ، فقال : «أنظروا في ذلك» ثم قال : إن محمداً ليس له سرّ من زيد بن لعي ، وأنا أكره أن يسمع ذلك قال : فذكرت ذلك لعلي بن بلال ، فقال : ما كان يصنع بالحائر وهو الحائر؟ فقدمت العسكر فدخلت عليه ، فقال لي : أجلس حين أردت القيام ، فلما رأيته آنس بي ، ذكرت قول علي بن بلال ، فقال : ألا قلت له : إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، كان يطوف بالبيت ويُقبِّل الحجر ، وحرمة النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ
__________________
(١٢١) ـ المصدر السابق / ٣٦٧ ـ ٣٦٨.
(١٢٢) ـ نفس المصدر / ٣٨٢.
والمؤمن أعظم من حرمة البيت ، وأمره الله أن يقف بعرفه ، وإنما هي من مواطن يحب الله أن يدعى فيها ، والحائر من تلك المواضع)(١٢٣) .
٨ ـ عن أبي هاشم الجعفري قال : (دخلت أنا ومحمد بن حمزة عليه ـ عليه السلام ؛ يعني الهادي ـ عليه السلام ـ نعوده وهو عليل ، فقال لنا : وجِّهوا قوماً إلى الحير من مالي ، فلما خرجنا من عنده ، قال لي : محمد بن حمزة المشير : يوجهنا إلى الحائر ، وهو بمنزلة من في الحائر ، قال : فعدت إليه فأخبرته ، فقال لي : ليس هو هكذا ، إنّ لله مواضع يحب أن يعبد فيها ، وحير الحسين ـ عليه السلام ـ من تلك المواضع. قال الحسين بن أحمد بن المغيرة : وحدذني أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد بن علي الرازي ـ المعروف بالوهوردي ـ بنيسابور بهذا الحديث ، وذكر في آخره غير ما مضى في الحديثيين الأوليين ، أحببت شرحه في هذا الباب ؛ لأنّه منه ، قال أبو محمد الوهوردي : وحدثني أبو علي محمد بن همّام (ره) ، قال : حدثني محمد الحميري ، قال حدثني أبو هاشم الجعفري قال : دخلت على أبي الحسن ، علي بن محمد ـ عليهم السلام ـ ، وهو محموم عليل ، فقال لي : يا أبا هاشم ، إبعث رجلاً من موالينا إلى الحير يدعو الله لي ، فخرجت من عنده فاستقبلني علي بن بلال ، فأعلمته ما قال لي ، وسألني أن يكون الرجل الذي يخرج ، فقال : السمع والطاع ، ولكني أقول : إنه أفضل من الحير ، إذا كان بمنزلة من في الحير ، ودعاؤه لنفسه أفضل من دعائي له بالحائر فأعلمته ـ صلوات الله عليه ـ ما قال ، فقال لي : قل له : كان رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ أفضل من البيت والحجر ، وكان يطوف بالبيت
__________________
(١٢٣) ـ النوري ، الميرزا حسين الطبرسي : مستدرك الوسائل ، ج ١٠ / ٣٤٦.
ويستلم الحجر ، وأنّ الله تبارك وتعالى بقاعاً يحبّ أن يدعى فيها ، فيستجيب لمن دعاه والحائر منها)(١٢٤) .
٩ ـ عن الحسين بن ثوير قال : (كنت أنا ويونس بن ظبيان ، والمفضل بن عمر ، وأبو سلمة السّرّاج جلوساً عند أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ وكان المتكلم منا يونس ، وكان أكبرنا سناً قلت : جعلت فداك ، إني أريد أزوره فكيف أقول ، وكيف أصنع؟ قال : إذا أتيت أبا عبد الله ـ عليه السلام ـ فاغتسل على شاطئ الفرات ، ثم البس ثيابك الطاهرة ، ثم امشِ حافياً في حرم من حرم الله وحرم رسوله ، وعليك بالتكبير والتهليل ، والتسبيح والتمجيد ، والتعظيم لله عَزّ وجَلّ كثيراً ، والصلاة على محمد وأهل بيته ، حتى تصير إلى باب الحير الخ)(١٢٥) .
١٠ ـ عن محمد بن مسلم قال : (خرجت إلى المدينة وأنا وجع ، فقيل له : محمد بن مسلم وجع. فأرسل إليّ أبو جعفر عليه السلام شراباً مع غلام ـ مغطّى بمنديل ، فناولنيه الغلام وقال لي : إشربه فإنه قد أمرني أن لا أبرح حتى تشربه ، فتناولته فإذا رائحة المسك منه ، وإذا بشراب طيب الطعم بارد ، فلما شربته قال لي الغلام : يقول لك مولاي : إذا شربته فتعال ففكرت فيما قال لي ، وما أقدر على النهوض قبل ذلك على رجلي ، فلما استقر الشراب في جوفي فكأنما نشطت من عقال ـ والحديث طويل إلى أن قال ـ : يأخذه الرجل فيخرجه من الحائر وقد أظهره ، فلا يمرّ بأحد من الجن به عاهة ولا دابة ولا شيء به آفة إلا شمّه ، فتذهب بركته لغيره ، وهذا الذي نتعالج به ليس هكذا ، ولولا ما ذكرت لك ، ما يمسح به شيء ولا شرب منه شيء إلا أفاق من ساعته ، وما هو إلا
__________________
(١٢٤) ـ المصدر السابق / ٣٤٦ ـ ٣٤٧.
(١٢٥) ـ الفيض الكاشاني ، الشيخ محمد محسن : الوافي ، ج ١٤ / ١٤٨٥ ـ ١٤٨٦.
كالحجر الأسود ، أتاه أصحاب العاهات والكفر والجاهلية ، وكان لا يتمسح به أحد إلا أفاق ، وكا كأبيض ياقوته فأسودّ حتى صار إلى ما رأيت. فقلت : جعلت فداك وكيف أصنع به ، فقال : أنت تصنع به مع إظهارك إياه ما يصنع غيرك ، تستخف به فتطرحه في خرجك وفي أشياء دنسه فيذهب ما فيه مما تريده له. فقلت : صدقت جعلت فداك ، قال : ليس يأخذه أحد إلا وهو جاهل بأخذه ولا يكاد يسلم بالناس. فقلت : جعلت فداك وكيف لي أن آخذه كما تأخذه؟ فقال لي : أعطيك منه شيئاً ، فقلت : نعم ، قال : إذا أخذته فكيف تصنع به؟ فقلت : أذهب به معي ، فقال : في أي شيء تجعله؟ فقلت : في ثيابي ، قال : فقد رجعت إلى ما كنت تصنع ، اشرب عندنا منه حاجتك ولا تحمله فإنه لا يسلم لك ، فسقاني منه مرتين ، فما أعلم أني وجدت شيئاً مما كنت أجد حتى إنصرفت)(١٢٦) .
ثانياً ـ في اللغة :
تناولت كتب اللغة لفظة (الحَائِر والحَيْر) كالتالي :
١ ـفي لسان العرب : «والحَيْرُ ، بالفتح : شِبْهُ الحَظِيرَة أو الحِمَى ، ومنه الحَيْرُ بكربلاء»(١٢٧) .
٢ ـفي كتاب العين : «والحائر : حوض يُسيَّبُ إليه مسيل الماء في الأمصار ، يُسمّى هذا الإسم بالماء ، وبالبصرة : حائر الحُجّاج ، معروف يابس لا ماء فيه ، وأكثر
__________________
(١٢٦) ـ ابو قولويه ، الشيخ جعفر بن محمد : كامل الزيارات / ٤٦٢ ـ ٤٦٥ (باب ٩١ ـ الحديث ٧).
(١٢٧) ـ ابن منظور ، محمد بن مكرم : لسان العرب ، ج ٤ / ٢٢٦.
الناس يُسمّونه : الحَيْر ، كما يقال لعائشة عَيْشة يستحسنون التخفيف وطرح الألف ، وإنما سُمّيَ حائراً ؛ لأنّ الماء يتحير فيه ، يرجع أقصاه إلى أدناه»(١٢٨) .
٣ ـفي مراصد الإطلاع : «الحائر موضع فيه قبر الحسين (عليه السلام) ؛ لأنّه في موضع مطمئن الوسط ، مرتفع الحروف»(١٢٩) .
٤ ـتاج العروس : «الحائر عليه السلام(١٣٠) بالعراق ، فيه مشهد الإمام المظلوم الشَّهيد أبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب ، رضي الله عنهم ؛ سُمّي لتَحَيَّر الماء فيه»(١٣١) .
٥ ـلسان العرب : «وقيل : الحائر المكان المطمئن ، يجتمع فيه الماء فيتحيّر لا يخرج منه ، والحائر بكربلاء ...»(١٣٢) . وبعد عرض هذه الأقوال ؛ نخرج بما يلي :
أ ـ إنّ المراد بالحائر لغة : المكان المطمئن الذي يجتمع فيه الماء فيحير ، أو شبه الحظيرة والحمى.
ب ـ في التفريق بين لفظة (الحائر والحير) يقول ابن منظور : «وقالوا : لهذه الدار حائر واسع ، والعامة تقول : حَيْرُ وهو خطأ» وقال أيضاً : «وبالبصرة حائر الحجاج ، معروف يابس لا ماء فيه ، وأكثر الناس يسميه الحير ، كما يقولون : لِعَائشَة عَيْشَةٌ ، يستحسنون التخفيف وطرح الألف»(١٣٣) .
__________________
(١٢٨) ـ الفراهيدي ، الخليل بن أحمد : كتاب العين ، ج ٣ / ٢٨٩.
(١٢٩) ـ البغدادي ، عبد المؤمن عبد الخالق : مراصد الإطلاع ، ج ١ / ٣٧٣.
(١٣٠) ـ المراد بـ(ع) رمز لكلمة موضع.
(١٣١) ـ الزبيدي ، السيد محمد مرتضى الحسيني : تاج ال عروس من جواهر القاموس ، ج ١١ / ١٠٩.
(١٣٢) ـ ابن منظور ، محمد بن مكرم : لسان العرب ، ج ٤ / ٢٢٣.
(١٣٣) ـ نفس المصدر.
«وقال الأصمعي : يقال للموضع المطمئن الوسط ، المرتفع الحروف حائر ، وجمعه حوران ، وأكثر الناس يسميه الحير ، كما يقولون لعائشة عيش ، والحائر : قبر الحسين بن علي «رضي الله عنه»»(١٣٤) .
ويرجع هذا القول الدكتور عبد الجواد الكليدار بقوله : «والحير وإن كان مخفف الحائر على ما يذهب إليه أهل اللغة كالحرث والحارث ، والمخفف يؤدي عادة نفس المعنى الذي يؤديه المخفف عنه ، ويقوم كل واحد منهما بدل الآخر بدون فرق أو تمييز ، غير أنّ العرف واستعمال التاريخ كأنهما خالفا القاعدة في هذا المورد ؛ لإختلاف ظاهر في مدلول اللفظين وكيفية إطلاقهما ، فخصص كل منهما لمعنى غير الآخر ، وإن تقارب مدلولها في الأصل ؛ لأنّ الحير أصبح في الإستعمال ـ حسب الظاهر ـ علماً لمدينة كربلاء نفسها ، بينما صار الحائر علماً لقبر الحسين (عليه السلام) ، كما يستفاد ذلك من إطلاق المؤرخين والجغرافيين لهما ، فمن ذلك قول معجم البلدان : «والحائر قبر الحسين بن علي (رضي الله عنه) ، وأنهم يقولون الحير بلا إضافة إذا عنوا كربلاء» ، ومفاد هذا القول : أنّ الحير بذاته والحير وإن كانا من أصل واحد ، وأحدهما مخفف الآخر إلا أنهما ليسا بمترادفين في الإستعمال ، وليس لهما مدلول واحد ؛ لأنّ الفرق بينهما في الدلالة كالفرق بين إسم كربلاء وبين اسم حرم الحسين في هذا اليوم ، فلعلّ من يقصد كربلاء دون أن يكون قاصداً لحرم الحسين وبالعكس»(١٣٥) .
__________________
(١٣٤) ـ الحموي ، شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت : معجم البلدان ، ج ٢ / ٢٠٨.
(١٣٥) ـ الكليدار ، الدكتور السيد عبد الجواد : تاريخ كربلاء وحائر الحسين (ع) / ٧٤.
أقول : لا مانع من القول بالترادف ؛ حيث أنّ المستفاد من كلمات اللغويين أن الحير مخفف الحائر ، فهما من أصل واحد ومؤداهما واحد ؛ وخير دليل على ذلك ، أنّ الأئمة عليهم السلام يُعَبِّرون عن تلك البقعة الطاهرة بـ(الحير) وتارة بـ(الحائر). وكذلك اللغويون يعبرون تارة بـ«ومنه الحير بكربلاء» وأخرى بـ : (والحائر بكربلاء).
فالإستعمال ؛ قد يكون في بداية الأمر يطلق على ما حول القبر ، ثم تطوروا في إطلاقه على كربلاء. كما أنّ إطلاق عامة الناس الحير أكثر من الحائر ، فكل هذا لا يؤثر على القول بالترادف.
ثالثاً ـ في التاريخ :
قد إتفق الرواة ، والمؤرخون ، والجغرافيون ، واللغويون ، على تسمية هذه البقعة الشريفة بـ(الحائر) ، بل من الواضح الذي لا ريب فيه ، أنه يوجد في لسان المعاصرين للأئمة عليهم السلام ومن قارب عصرهم ـ وخصوصاً من عصر الإمام الصادق عليه السلام ـ ، وفي كتب الأخبار والسير إطلاق الحائر على هذه البقعة الشريفة كثيراً ، بحيث قد بلغ حد الظهور ولو بضرب من التوسعة والمجاز ، والذي نريد بحثه هو ما يلي :
أ ـ وجه تسميتها بالحائر أو الحير :
ولعل أهم ما توصل إليه الباحثون في وجه التسمية هو التالي :
١ ـ قال العلامة الكبير المحقق السيد جعفر بحر العلوم (قده) : «أما ما كان مشتملاً على لفظ الحاير ـ وهو بعد الألف ياء مكسورة وراء ساكنة ـ ؛ فهو في الأصل حوض ينصب إليه مسيل الماء من الأمطار ، سمي بذلك ؛ لأنّ الماء يتحير فيه يرجع من أقصاه إلى أدناه ، وبهذه المناسبة أطلق لفظ الحاير على
موضع قبره عليه السلام ؛ لوقوعه في أرض منخفضة ، كما هو المشاهد من الصحن الشريف من جوانبه الأربع ، خصوصاً باب الزينبية وباب الصدرة ، ولا وجه لما هو مشهور من وجه التسمية بذلك ، من جهة أنّ المتوكل العباسي لما أمر بحرث قبره عليه السلام أطلق الماء عليه ، فكان لا يبلغه ، وإن صدقت القصة ـ إذ في كثير من الأخبار الصادرة قبل وجود المتوكل ، إطلاق لفظ (الحاير) على موضع قبر الحسين عليه السلام ، ـ فإن ولادة المتوكل سنة (٢٠٦ هـ) ، ووفات الصادق عليه السلام سنة (١٤٨ هـ) ، ولا يصح أن يكون الإطلاق باعتبار الواقعة المتأخرة»(١٣٦) .
٢ ـ وقال الدكتور عبد الجواد الكليدار (ره) : «ومع أنّ إسم الحير بقي يطلق على كربلاء إلى عصر متأخر كما مر بيانه ، فلا يعلم اليوم بالضبط متى اندرس إستعماله؟ ، أو في أي قرن من القرون الأخيرة غاب هذه الإسم عن الأنظار نهائياً ، ليحل محله إسم (الحائر) وحده في العرف والتاريخ ، علماً لكربلاء ولقبر الحسين ـ عليه السلام ـ معاً. على أنّ هناك بمسافة غير بعيدة في جنوب كربلاء موضعاً آخر ، يشتق إسمه هو والحائر من مادة واحدة في اللغة ، وهو (الحيرة) ، فكأنهما يرجعان حتى في وجه التسمية إلى أصل واحد ، خصوصاً إذا ما لا حظنا أنّ كل واحد من هذين الموضعين يقع بجانب الآخر تقريباً ، فهل هناك إذن ، من صلة تاريخية أو جغرافية ، أو من أي نوع آخر كانت تجمع بين إسم الحائر والحير بكربلاء ، وبين إسم الحيرة بانلجف؟ فإنّ هذا الأمر لمن الأمور التي لا يمكن البث فيها بصورة قاطعة ، وذلك لعدم وجود مستندات تاريخية يمكن إستنباط شيء منها ، غير أنّ إقتراب الموضعين ، وتقارب الإسمين ورجوعهما إلى أصل واحد في اللغة ،
__________________
(١٣٦) ـ بحر العلوم ، السيد جعفر محمد باقر : تحفة العالم في شرح خطبة المعالم ، ج ١ / ٣٠٤.
يجعل الباحث يتسائل عن علّة هذا الأمر ، أو على الأقل عن هذه الصدفة في وجه التسمية بينهما ، أكانت ذلك لأمر واقعي ، أو على سبيل الإتفاق؟»(١٣٧) .
نتيجة البحث :
بعد ذكر القولين السابقين نخرج بالنتيجة التالية :
١ ـ بناء على ما تقدم ، يمكن أن نستنبط بعض الصلة بين مسمى الحائر والحيرة ، من صلات القومية التاريخية والجغرافية ، والقول بأنّ هذا النوع من البناء في هذه المنطقة يسمى بهذه التسمية قديماً ، فسميت (الحيرة) لوجود الحير فيها ، وسمي (قبر الحسين عليه السلام) وما أحاط به بالحائر ، ويؤيد هذا الوجه الحديث التالي :
روى جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (أرسل علي عليه السلام إلى أسْقُف نَجْرَان يسأله عن أصحاب الأخدود ، فأخبره بشيء ، فقال عليه السلام : ليس كما ذكرت ، ولكن سأخبرك عنهم ، إنّ الله بعث رجلاً حبشياً نبيّاً ـ وهم حبشة ـ ؛ فكذبوه ، فقاتلهم فقتلوا أصحابه ، وأسروه وأسروا أصحابه ، ثم بنوا له حَيْراً ، ثم ملأوه ناراً ، ثم جمعوا الناس فقالوا : من كان على ديننا وأمرنا فليعتزل ، ومن كان على دين هؤلاء ؛ فليرمِ نفسه في النار معه ، فجعل أصحابه يتهافتون في النار ، فجاءت امرأة معها صبيّ لها ابن شهر ، فلمّا هجمت على النار ؛ هابت ورقّت على إبنها ، فنادها الصبي : لا تعابي وارميني ونفسك في النار ، فإنّ هذا والله في الله قليل. فرمت بنفسها في النار وصبّيها ، وكان ممن تكلم في المهد)(١٣٨) .
فالمستفاد من (ثم بنوا له حَيْرَاً) ، أنّ المراد بالحير هو : شبه الحظيرة أو الحمى.
__________________
(١٣٧) ـ الكليدار ، الدكتور السيد عبد الجواد : تاريخ كربلاء وحائر الحسين (ع) / ٣٦.
(١٣٨) ـ البحراني ، السيد هاشم : البرهان في تفسير القرآن ، ج ٨ / ٢٥٣ ـ ٢٥٤.
٢ ـ إنّ الحائر في عرف ذلك العصر ؛ هو السور الذي كان يحيط بالقبر المطهر حريماً له ، وصوناً للمشهد من الطوارئ ، ولربما يكون بمثابة مأوى وملجأ للمنقطعين من الزائرين يأوون في داخله ، كما جرت عليه العادة فيما بعد في هندسة العتبات المقدسة ، بتزويد أسوارها الخارجية بحجرات في أطرافها من الداخل لمثل هذه الغاية.
٣ ـ لعلّ بإطلاق مثل هذا الإسم على هذا النوع من البناء في ذلك العصر ، أرادوا التكتم والتستر به كي لا يثيروا الشبهة حوله ، فتتحرك ضغينة الأمويين على الزائرين والإنتقام منهم ؛ ولذا توجد مسالح على حدود كربلاء في العهد الأموي ، لمنع الزائرين من الوصول إليها ومعاقبتهم حتى القتل ، وكان الزائرون يتخذون الغاضرية أو نينوى ملجئاً ومحطاً لرحالهم ، وذلك إتباعاً لتعليمات الإمام الصادق عليه السلام ـ كما في رواية أبي حمزة الثمالي ـ : (إذا أردت الوداع بعد فراغ من الزيارات ، فأكثر منها ما استطعت ، وليكن مقامك بنينوى أو الغاضرية ، ومتى أردت الزيارة فاغتسل وزر زورة الوداع)(١٣٩) .
وبعد هذا البحث والتوضيح نخرج بالنتيجة التالية :
أولاً ـ المستفاد من المرويات أو الأنبياء حاروا لما مروا بهذه الأرض ، بل أن جميع المخلوقات وخصوصاً البشر حاروا في أمر هذه الأرض باعتبار ما حلّ فيها من المصيبة على الحسين وأهل بيته عليهم السلام ، وهذا ما نقرأه واضحاً من كتابات البشر بمختلف لغاتهم ودياناتهم.
ثانياً ـ إنها حضيرة وحمى لكل من أراد التوسل وقضاء الحاجات. فهو مصباح دجى وسفينة نجاة الحائرين.
__________________
(١٣٩) ـ ابن قولويه ، الشيخ جعفر بن محمد : كامل الزيارات / ٤٣٧ (باب ٨٤ ـ الحديث ٢).
إستنتاج المؤلف :
بعد عرض ما ذكره أعلام اللغة والتاريخ والفقه في سبب تسمية هذه البقعة الطاهرة بـ(الحير أو الحائر) ، يمكن إستنتاج بعض الأمور التي لها إرتباط بسبب التسمية ، من خلال النصوص الواردة في السيرة الحسينية ، وهي كالتالي :
أولاً ـ حيرة الأنبياء في كربلاء :
تذكر الروايات(١٤٠) أن جمعاً من الأنبياء مروا بكربلاء وهم : آدم ، ونوح ، وإبراهيم ، وإسماعيل ، وموسى ، وسليمان ، وعيسى (عليهم السلام) ، وكل منهم أُصيب بحدث حَيّره ، ثم أُخبروا من قبل الوحي بما سيحدث على الحسين عليه السلام في هذا المكان.
ثانياً ـ حيرة أفراس الحسين (عليه السلام) في كربلاء :
ونَصّ على ذلك المؤرخون في السيرة الحسينية : «ففي منتخب المرائي ، ومقتل أبي مخنف : لما وصلوا كربلاء ـ وهو يوم الأربعاء ـ إذ وقف الجواد الذي تحت الحسين عليه السلام ولم ينبعث من تحته ، وكلما حَثّه على المسير لم ينبعث خطوة واحدة يميناً وشمالاً ، فركب غيره فلم ينبعث من تحته ، فلم يزل الحسين عليه السلام يركب فرساً فرساً حتى ركب ستة أفراس ، وهي لا تخطو تحته خطوة واحدة ، فلما نظر إلى ذلك ؛ قال لهم : يا قوم أي موضع هذا؟ إلخ»(١٤١) .
ثالثاً ـ حيرة أصحاب الحسين (عليه السلام) في تصرفاته وقتاله للقوم :
وإلى هذا يشير حديث الإمام الجواد عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام قال : (قال علي بن الحسين عليهما السلام : لما إشتدّ الأمر بالحسين بن علي بن أبي طالب ؛ نظر إليه من
__________________
(١٤٠) ـ راجع بحار الأنوار ، ج ٤٤ / ٢٤٢ ـ ٢٤٤.
(١٤١) ـ القزويني ، السيد رضي بن نبي : تظلم الزهراء / ١٧٨ ـ ١٧٩.
كان معه فإذا هو بخلافهم ؛ لأنهم كلما إشتدّ الأمر ؛ تغيّرت ألوانهم ، وارتعدت فرائصهم ، ووجلت قلوبهم ، وكان الحسين عليه السلام وبعض من معه من خصائصه تشرق ألوانهم ، ونهدئ جوارحهم ، وتسكن نفوسهم. فقال بعضهم لبعض : أنظروا لا يبالي بالموت. فقال لهم الحسين عليه السلام : صبراً بني الكرام ، فما الموت إلا قنطرة تعبر بكم عن البؤس والضراء إلى الجنان الواسعة ، والنعيم الدائمة ، فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر؟ وما هو لأعدائكم إلا كمن ينتقل سجن المؤمن وجنة الكافر ، والموت جسر هؤلاء إلى جناتهم ، وجسر هؤلاء إلا جحيمهم ، ما كذبت ولا كذبت)(١٤٢) .
رابعاً ـ حيرة الجيش في أمر الرضيع :
قال السيد هبة الدين الشهرستاني (ره) : «... فالحسين عليه السلام بعدما خلى رحله من الماء وطال على أهله الظمأ ـ حتى جفت المراضع وشحت المدامع ـ تناول طفله الرضيع ـ واسمه علي أو عبد الله ـ ليقدمه إلى العدو وسيلة لرفع الحجر من الماء ، فأشرف على الأعداء بتلك البنية المعصومة من أية جانحة أو جارحة قائلاً : (يا قوم! إن كنا في زعمكم مذنبين فما ذنب هذا الرضيع؟ وقد ترونه يتلظى عطشاً ، وهو طفل لا يعرف الغاية ولم يأت بجناية ، ويلكم اسقوه شربة ماء ، فقد جفت محالب أمه)ز فتلاوم القوم بينهم بين قائل : لا بد من إجابة الحسين عليه السلام فإن أوامر ابن زياد بمنع الماء خصت الكبار دون الصغار ـ والصغير استثنته الشرائع والعواطف من كل جريمة وانتقام ، حتى لو كان من ذراري الكفار. وقائل : إن الحسين قد بلغ الغاية من الظمأ والضرورة ، فإن
__________________
(١٤٢) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٤٤ / ٢٩٧.
صبرتم عن سقايته سويعه أسلم أمره إليكم وتنازل لكم. فخشي ابن سعد من طول المقام والمقال أن يتمرد عليه جيشه المطيع ، فقال لحرملة : اقطع نزع القوم وكان من الرماة القساة ، فعرف عرض ابن سعد فرمى الرضيع بسهم نحره به ، وصار الحسين يأخذ دمه بكفه ، وكلما إمتلأت كفه دماً رمى به إلى السماء ، قائلاً : (اللهم لا يكون أهون عليك من فصيل يعنى فصيل ناقة صالح)(١٤٣) .
خامساً ـ حيرة القوم في قتل الحسين عليه السلام :
قال أبو مختف في مقتله : «ولقد مكث طويلاً من النهار ، ولو شاء الناس أن يقتلوه لفعلوا ولكنهم كان يتقي بعضهم ببعض ، ويجب هؤلاء أن يكفيهم هؤلاء ، قال : فنادى شمر في الناس : ويحكم ماذا تنظرون بالرجل؟ أقتلوه ثكلتكم أمهاتكم إلخ»(١٤٤) . وإلى هذا المعنى يشير الشيخ القرشي بقوله : «وكانت هيبته تأخذ بمجامع القلوب ، حتى قال بعض أعدائه : لقد شغلنا جمال وجهه ونور بهجته عن الفكرة في مقتله. وما إنتهى إليه رجل إلا إنصرف كراهية أن يتولى قتله»(١٤٥) ، وإلى هذا يشير إمامنا الصادق عليه السلام بقوله : (لما ضرب الحسين بن علي عليه السلام بالسيف ، ثم إبتدر ليُقطع رأسه ، نادى منادٍ من قبل ربّ العزّة تبارك وتعالى من بطنان العرش فقال : ألا أيتها الأمة المتحيرة الظالمة بعد نبيها ، لا وفقكم الله لأضحى ولا فطر. قال : ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : لا جرم والله ، ما وفقوا ولا يوفقون أبداً حتى يقوم ثائر الحسين عليه السلام)(١٤٦) .
__________________
(١٤٣) ـ الشهرستاني ، السيد هبة الدين : نهضة الحسين / ١٢٧ ـ ١٢٨.
(١٤٤) ـ أبو مخنف ، لوط بن يحيى : مقتل الحسين / ٢٠٠.
(١٤٥) ـ القرشي ، الشيخ باقر شريف : حياة الإمام الحسين ، ج ٣ / ٢٩٠.
(١٤٦) ـ الصدوق ، الشيخ محمد بن علي : أمالي الصدوق / ١٤٢. (المجلس ٣١ ـ حديث ٥).
سادساً ـ حيرة بنات الرسالة في كربلاء :
إنّ من يقرأ السيرة الحسينية ، يلاحظ أنّ لبنات النبوة مواقف أحارتها وأذهلتها ، وأوجلت قلوبها ، وخصوصاً ساعة الوداع ، حينما جاءها سيد الشهداء عليه السلام مودعاً ، فقد ذابت أساً وتجرعت غصصاً ، حينما رأت عمادها وسياج صونها بتلك الحالة المشجية ، حيث الدماء تغلي كما أشار إلى ذلك الإمام زين العابدين عليه السلام بقوله : (ضمني والدي عليه السلام إلى صدره حين قتل والدماء تغلي)(١٤٧) . من الذي يستطيع أنّ يصوِّر الحسين عليه السلام مع عياله ، وقد خرجت كسرب القطا المذعورة ، وتعلقن بأذياله بين طفلة تنشد الماء ، ووالهة أذهلها المصاب؟
يقول الشيخ عباس القمي (ره) مصوراً لنا هذا الموقف : «إنّ مصاب الإمام الحسين عليه السلام كلها لها في القلب حرقة ، وفي العين دمعة ، لكن مصيبة الوداع لعلها أشد تأثيراً وإيلاماً في النفس ، خاصة وأنّ صغاره وأطفاله ، وبني قرباه ممن كانوا منه بمنزلة أولاده عليه السلام ، كانوا يحيطون به جميعاً وهم يبكون ويعولون وينقل عن عبد الله بن الحرّ قوله : قدم عليّ الحسين ولحيته كأنها جناح غراب ، فما رأيت أحداً قط أحسن منه ، ولا أملأ للعين منه ، فما رفقت على أحد رقّني عليه حين رأيته يمشي والصبيان حوله»(١٤٨) .
إن هذه الساعة من أعظم المصائب على قلب الزهراء عليها السلام ، ومما يؤيد ذلك ما يلي :
__________________
(١٤٧) ـ القمي ، الشيخ عباس : منتهى الآمال ، ج ١ / ٥٣٣.
(١٤٨) ـ نفس المصدر.
١ ـ «رأى أحد الخطباء ليلة العاشر فاطمة الزهراء عليها السلام قالت له : إذكر للناس مصيبة ولدي الحسين عليه السلام. قال : سيدتي أنا أذكر مصرعه. قالت : ما قصدت هذا ، ولكن أذكر للشيعة لمّا ودع الحسين عليه السلام بناتي وبقين حيارى ليس مهن أحد غريبات. فانتبه وهو ينادي : واحسيناه ، وذكر هذا الأمر للشيعة»(١٤٩) .
٢ ـ حكاية الميرزا يحيى الأبهري قال : «رأيت في منامي العلامة المجلسي (ره) في صحن سيد الشهداء المطهّر ، في الطرف الأدنى عند باب قبة الصفا ، وهو مشغول بالتدريس ، فبعد أن قال موعظة ، وأراد الشروع في الحديث عن المصائب ؛ أتاه شخص فقال : إنّ الصديقة الطاهرة سلام الله عليها تقول لك : إذكر المصائب المشتملة على وداع ولدي الشهيد.
فأقبل المجلسي يتحدث عن مصيبة الوداع ، وأخذ الناس يبكون بكاء شديداً لم أرَ مثله عمري. أقول : ورد في الرؤيا نفسها الحسين (عليه السلام) قال له : قولوا لأوليائنا وأمنائنا يهتمون في إقامة مصائبنا»(١٥٠) .
إنّ محنة الإمام في توديعه لعياله من أعظم المحن والخطوب ، فما حاله وهو ينظر بعلمه إلى مستقبل هذه الودائع النبوية ، كيف يتراكضن في ارض كربلاء وقد حُرقت خيامهن والسياط على متونهن. قالت فاطمة الصغرى : (كنت واقفة بباب الخيمة ، وأنا أنظر إلى أبي وأصحابه مجزرين كالأضاحي على الرمال ، والخيول على أجسادهم تجول ، وأنا أفكر فيما يقع علينا بعد أبي ، يقتلوننا أو يأسروننا ، فإذا برجل على ظهر جواده يسوق النساء بكعب رمحه
__________________
(١٤٩) ـ آل إدريس ، الخطيب السيد محمد : لطائف وطرائف / ٤٠.
(١٥٠) ـ القمي ، الشيخ عباس : منتهى الآمال ، ج ١ / ٥٣٣.
وهنّ يلذن بعضهم ببعض ، وقد أخذ ما عليهن من أسورة وأخمرة ، وهنّ يصحن : واجداه وابتاه واعلياه واقلة ناصراه واحسيناه ، أما من مجير يجيرنا ، أما من ذائد يذود عنا ، قالت : فطار فؤادي ، وارتعدت مفاصلي ، فجعلت أحيل طرفي يميناً وشمالاً على عمتي أم كلثوم ، خشية منه أي يأتيني ، فبينما أنا على هذه الحال ، فإذا به قد قصدني فذهلت خشية منه ، وإذا بكعب الرمح بين كتفي ، فسقطت على وجهي ، فخرم أذني وأخذ قرطي ومقنعتي ، وترك الدماء تسيل على دخدي ورأسي تصهره الشمس ، وولى راجعاً للخيام وأنا مغشياً عليّ ، وإذا أنا بعمتي عندي تبكي وتقول : قومي يا بنية نمضي فما أعلم ما جرى على البنات وعلى أخيك العليل ،فقمت وقلت : يا عمتاه ، هل من خرقة أستر بها رأسي عن أعين النظارة؟ فقالت : يا ابنتاه وعمتك مثلك. فرأيت رأسها مكشوفاً ومنتها إسودّ من الضرب ، فما رجعنا إلى الخيمة إلا وقد نهبت وجميع ما فيها ، وأخي مكبوب على وجهه لا يطيق الجلوس والقيام من كثرة الجوع والعطش والسقام ، فجعلنا نبكي عليه ويبكي علينا)(١٥١) .
هذه بعض المآسي المحيرة ، التي أذابت القلوب وأبكت حتى العدو الغاشم ، وبهذا نكتفي.
ولقد أجاء السيد حيدر الحلي (ره) في تصوير هذه المآسي في أبياته التالية :
وحائرات أطار القوم أعينها |
رعباً غداة عليها خدرها هجموا |
|
كانت بحيث عليها قومها ضربت |
سرادقاً أرضه من عزهم حرم |
|
يكاد من هيبة أن لا تطوف به |
حتى الملائك لولا أنهم خدم |
|
فغودرت بي أيدي القوم حاسرة |
تسبى وليس لها من فيه تعتصم |
__________________
(١٥١) ـ ابن نما ، الشيخ جعفر بن محمد : مثير الأحزان ، ج ٢ / ٩١ ـ ٩٢.
نعم لموت جيدها بالعتب هاتفة |
بقومها وحشاها ملؤه ضرم |
|
عجت بهم مذ على أبرادها اختلفت |
أيدي العدو ولكن من لها بهم(١٥٢) |
سابعاً ـ حيرة القوم في قتل العليل (عليه السلام) :
ويشير إلى هذا الموقف المأساوي السيد المقرّم (ره) بقوله : «وإنتهى القوم إلى علي بن الحسين وهو مريض على فراشه لا يستطيع النهوض ، فقائل يقول : لا تدعوا منهم صغيراً ولا كبيراً. وآخر يقول : لا تعجلوا حتى نستشير الأمير عمر بن سعد ، وجَرّد الشمر سيفه يريد قتله ، فقال له حميد بن مسلم : يا سبحان الله أتقتل الصبيان؟! إنما هو صبي مريض! فقال : إن ابن زياد أمر بقتل أولاد الحسين ، وبالغ ابن سعد في منعه ، خصوصاً لما سمع العقيلة زينب ابنة أمير المؤمنين تقول : لا يقتل حتى أقتل دونه ، فكفوا عنه»(١٥٣) .
ثامناً ـ حيرة بني أسد في مواراة الأجساد الطاهرة :
إختلفت الروايات في من دفن الحسين عليه السلام ، وأهل بيته ، وصحبه الكرام ، هل بنو أسد ، أو الإمام زين العابدين عليه السلام؟
إلا أنّ الموافق لمعتقد الإمامية الإثني عشرية ، أنّ الإمام لا يلي أمره إلا إمام مثله ، فالصحيح أنّ الإمام زين العابدين عليه السلام ، خرج من سجن ابن زياد (لع) في ال كوفة إلى كربلاء عن طريق المعجزة ، في الثالث عشر من المحرم لمواراة الأجساد الطاهرة.
__________________
(١٥٢) ـ المقرم ، السيد عبد الرزاق : مقتل المقرّم / ٣٠٢.
(١٥٣) ـ نفس المصدر / ٣٠١.
قال السيد المقرّم (ره) : «ولما أقبل السجاد عليه السلام ؛ وجد بني أسد مجتمعين عند القتلى متحيرين لا يدرون ما يصنعون ، ولم يهتدوا إلى معرفتهم ، وقد فرقا لقوم بين رؤوسهم وأبدانهم ، وربما يسألون من أهلهم وعشيرتهم!!.
وأخبرهم (عليه السلام) عما جاء إليه من مواراة هذه الجسوم وأوقفهم على أسمائهم ، كما عَرّفهم بالهاشميين من الأصحاب ، فارتفع البكاء والعويل ، وسالت الدموع منهم كل مسيل ، ونشرت الأسديات الشعور ، ولطمن الخدود»(١٥٤) .
تاسعاً ـ حيرة البشر في قراءة ودراسة يوم كربلاء :
إنّ فاجعة الطف الأليمة ، ظلت مصدراً للحزن والتفجع ، تذوب مها النفوس حسرة وأساً على امتداد التاريخ ، منذ وقوعها لحد الآن ، فاجعة لا تضاهيها فاجعة ومأساة ، في خلودها وبقائها حية في القلوب والأذهان ، بل لم يبق تيار متلاطم على مدى التاريخ مثل عاشوراء ، تركت هذه الفاجعة أثراً بليغاً على أفكار بني البشر.
يقول الكاتب المسيحي (أنطون بارا) : «لم تحظ ملحمة إنسانية في التاريخين القديم والحديث ، بمثل ما حظيت به ملحمة الإستشهاد في كربلاء من إعجاب ودرس وتعاطف»(١٥٥) .
ويقول «توماس ماساريك» : «على الرغم من أن القساوسة لدينا يؤثرون على مشاعر الناس عبر ذكر مصائب المسيح ، إلا أنك لا تجد لدى أتباع المسيح ذلك الحماس والإنفعال الذي تجده لدى أتباع الحسين (عليه السلام) ،
__________________
(١٥٤) ـ المصدر السابق / ٣٢٠.
(١٥٥) ـ بارا ، أنطون : الحسين في الفكر المسيحي / ٥٩.
ويبدو أن سبب ذلك يعود إلى أن مصائب الحسين (عليه السلام) لا تمثل إلا قشّة أمام طود عظيم»(١٥٦) . نعم بقيت هذه المأساة طلسماً محيراً للعقول ، في فضاعتها وإعتراف مقترفيها بعظيم ما جنوا ، وفي دراستها وفهم مغزاها. إذن ، هناك ثلاثة عناوين ينبغي بحثها كالتالي :
الأول ـ عظمة المأساة وفضاعتها :
تظهر عظمة هذه المأساة وفضاعتها على لسان من عاش أحداثها وهم أهل البيت عليهم السلام ، وخصوصاً الإمامين السجاد والباقر عليهما السلام ، وقد روي عنهما ما يلي :
١ ـ قال الإمام السجاد عليه السلام في خطبته ـ عندما رجع إلى المدينة ونزل بالقرب منها قبل أن يدخلها ـ (أيها القوم ، إنّ الله وله الحمد إبتلانا بمصائب جليلة ، وثلمة في الإسلام عظيمة ، قتل أبو عبد الله عليه السلام وعترته ، وسبي نساؤه وصبيته ، وداروا برأسه في البلدان من فوق عالي السنان ، وهذه الرزية التي لا مثلها رزية.
أيها الناس : فأي رجالات منكم تسرون بعد قتله؟ أم أيّة عين منكم تحبس دمعها وتضن ععن إنهمالها؟ فلقد بكت السبع الشداد لقتله ، وبكت البحار بأمواجها ، والسماوات بأركانها ، والأرض بأرجائها ، والأشجار بأغصانها ، والحيتان في لجج البحار ، والملائكة المقربون ، وأهل السماوات أجمعون.
أيها الناس ، أي قلب لا ينصدع لقتله؟ أم أي فؤاد لا يحنّ إليه؟ أم أي سمع يسمع هذه الثلمة التي ثلمت في الإسلام؟!
أيها الناس : أصبحنا مطرودين مشردين مذودين ، شاسعين عن الأمصار ، كأنا أولاد ترك وكابل ، من غير جرم اجترمناه ، ولا مكروه ارتكبناه ، ولا ثلمة
__________________
(١٥٦) ـ محدثي ، جواد : موسوعة كربلاء / ٢٩٢.
في الإسلام ثلمناه ، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ، إن هذا إلا إختلاق ، فوالله لو أنّ النبي تقدم إليهم في قتالنا كما تقدم إليهم في الوصاية بنا لما زادوا على ما فعلوا بنا ، فإنا إليه راجعون من مصيبة ما أعظمها ، وأوجعها ، وأفجعها ، وأكظمها ، وأفظعها ، وأمرّها ، وأفدحها ، فعند الله نحتسب فيما أصابنا ، وبلغ بنا إنه عزيز ذو انتقام)(١٥٧) .
٢ ـ وعَبّر عنها الإمام الباقر عليه السلام بأن قال : (كان أبي مبطوناً يوم قتل أبوه صلوات الله عليهما وكان في الخيمة ، وكنت أرى موالينا كيف يختلفون معه ، يتبعونه بالماء ، ويشدّ على الميمنة مرّة ، وعلى القلب ولقد قتلوه قتلة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقتل بها الكلاب ، لقد قتل بالسيف ، والسنان ، وبالحجارة ، وبالخشب ، وبالعصا ، ولقد أوطأوه الخيل بعد ذلك)(١٥٨) .
وأما بالنسبة إلى عامة الناس ؛ فعبروا عن هذه الفاجعة بما يلي :
قال البيروني : «لقد فعلوا بالحسين ما لم يفعل في جميع الأمم بأشرار الخلق من القتل بالسيف والرمح والحجارة وإجراء الخيول ، وقد وصل بعض هذه الخيول إلى مصر ، فقلعت نعالها وسمرت على أبواب الدور تبركاً ، وجرت بذلك السنة عندهم ، فصار أكثرهم يعمل نظيرها ويعلق على أبواب الدور»(١٥٩) .
الثاني ـ إعتراف الجناة بعظيم ما جنوا :
من قرأ السيرة الحسينية ؛ لاحظ أنّ فيها عدة مواقف تثير الدهشة والإستغراب من أعداء أهل البيت عليهم السلام ، نذكر منها ما يلي :
__________________
(١٥٧) ـ القزويني ، السيد رضي بن نبي : تظلم الزهراء / ٣٠٧ ـ ٣٠٨.
(١٥٨) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٤٥ / ٩١.
(١٥٩) ـ المقرّم ، السيد عبد الرزاق : مقتل الحسين / ٣٠٣.
«قال هلال بن نافع : كنت واقفاً نحو الحسين وهو يجود بنفسه ، فوالله ما رأيت قتيلاً قط مضمخاً بدمه أحسن منه وجهاً ولا أنور! ولقد شغلني نور وجهه عن الفكرة في قتله! فاستقى في هذه الحال ماء فأبوا أن يسقوه»(١٦٠) .
وذكر الشيخ الصدوق (ره) في كتابه (الأمالي) ـ بإسناده عن فاطمة بنت الحسين عليه السلام قالت : (دخلت الغاتمة (العامة) علينا الفسطاط وأنا جارية صغيرة وفي رجلي خلخالان من ذهب ، فجعل يفض الخلخالين من رجلي وه ويبكي ، فقلت : ما يبكيك يا عدو الله؟! فقال : كيف لا أبكي وأنا اسلب ابنة رسول الله؟! فقلت : لا تسلبني. قال : أخاف أن يجيء غيري فيأخذه. قالت : وانتهبوا ما في الأبنية حتى كانوا ينزعون الملاحف عن ظهورنا)(١٦١) .
وذكر السيد القزويني (ره) في كتابه (تظلم الزهراء) : «... فصاح ابن سعد : اضرموا عليهم النار في الخيمة. وقيل له : يا ويلك يا عمر ، ما كفاك ما صنعت بالحسين عليه السلام ، وتريد تحرق حرم رسول الله بالنار ، لقد عزمت أن تخسف بنا الأرض؟! فأمرهم بعد ذلك بنهب ما في الخيم»(١٦٢) .
الثالث ـ دراستها وفهم مغزاها :
إنّ صدى هذه الفاجعة المأساوية في كربلاء ، أثّر على الفكر البشري ، حيث أدى إلى عرض الكثير من الآراء حول دراستها وتحليلها ، وفهم مغزاها ، وهذا ما نراه واضحاً من خلال التالي :
__________________
(١٦٠) ـ المصدر السابق / ٢٨٣.
(١٦١) ـ الصدوق ، الشيخ محمد بن علي : أمالي الصدوق / ١٤٠ (المجلس ٣١ ـ الحديث ٢).
(١٦٢) ـ القزويني ، السيد رضي بن نبي : تظلم الزهراء / ٢٢٨.
١ ـ قال العلايلي : «والحق أنا لا نزال من فهم عصر الحسين ، والأحداث التي استطيرت واستشرت فيه على غموض وخفاء ، وذلك لأنّ الأقلام التي تناولته منذ أول عهد العرب بكتابة التاريخ لم تكن بريئة على إطلاق القول ، بل دارت على هدمة أغراض شتى بين النزعة المذهبية والزلفى من السلطة الغالبة. وجدير أن يتكيف تاريخ الحسين من بين هذه الأقلام بكيفية تجعل له لوناً مبهماً ، وتضفي عليه أستاراً ضعيفة ، تتركنا في حيرة من أن لا نصدق شيئاً أو نصدق كل شيء ، ولكن هاتين صفتان من السلب والإيجاب ، يمكن من بعدها أن نقتصد ونتحرى في جنب أخبار التاريخ بحيث نخرج بصفة ثالثة تقوم على النفي والإثبات جميعاً ، وعلى الوضع والرفع معاً ، مما قد نفضي منه إلى ما تطمئن إليه حقيقة ، ونشعر معه بشعور الصدق ، ونجد منه برد اليقين»(١٦٣) .
٢ ـ وقال الشيخ كاشف الغطاء (ره) : «إنّ التضحية والمفادات التي تسامى وتعالى بها إمام الشهداء ، وأبو الأئمة يوم الطف من أي ناحية نظرت إليها ، ومن كل وجهة إتجهت لها متأملاً فيها ، أعطتك دروساً وعبراً ، وأسراراً وحكماً تخضع لها الألباب ، وتسجد في محراب عظمتها العقول ، واقعة الطف وشهادة سيد الشهداء وأصحابه في تلك العرصات ، كتاب مشحون بالآيات الباهرات ، والعظات البليغة فهي :
كَالبَدْرِ مِن حيثُ إشتَفَتّ وَجَدْتَه |
يهدي إلى عينيك نوراً ثاقباً |
|
أو : كالشّمس في كَبِدِ السِّماءِ ونورها |
يغشى البلاد مشارقاً ومغارباً |
|
أو : كالبحر يمنح للقريب جواهراً |
غرراً ويبعث للبعيد سحائباً»(١٦٤) |
__________________
(١٦٣) ـ العلايلي ، عبد الله : الإمام الحسين / ١٥.
(١٦٤) ـ كاشف الغطاء ، الشيخ محمد حسين ، جنّة المأوى / ١٧٨ ـ ١٨٩.
تاريخ بناء الحائر الحسيني :
الحائر الحسيني : هو المحوّطة المقدّسة لقبر الحسين عليه السلام ، التي حدّدها الإمام الصادق عليه السلام بـ(عشرين أو خمسة وعشرين ذراعاً من جوانب القبر المقدس).
وإختلف المؤرخون في أول من بني هذا الحائر ، وعلى أي صفة كالتالي :
١ ـ أوّل من بنى القبر الشريف بنو أسد ، الذين دفنوا الحسين عليه السلام وأصحابه ، وأشار إلى هذا ابن طاووس (قده) بقوله : «إنهم أقاموا رسماً لقبر سيد الشهداء ، بتلك البطحاء يكون علماً لأهل الحق»(١٦٥) . وإلى هذا القول ذهب السيد محسن الأمين (قده). واعتمد السيدان : ابن طاووس والأمين على رواية زائدة ، عن علي بن الحسين عليه السلام ، عن عمته زينب ، عن أم أيمن ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ـ في حديث طويل ـ ، وفيه قال : (... ثم يبعث الله قوماً من أمتك لا يعرفهم الكفّار ، ولم يشركوا في تلك الدماء بقول ولا فعل ولا نيّة ، فيوارون أجسامهم ، ويقيمون رسماً لقبر سيد الشهداء بتلك البطحاء ، يكون علماً لأهل الحق ، وسبباً للمؤمنين إلى الفوز)(١٦٦) .
وفي لفظ آخر : (مالي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وأخوتي ، فوالله إنّ هذا العهد من الله إلى جدك وأبيك ، ولقد أخذ الله ميثاق أناس لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض ، وهم معروفون في أهل السماوات ، أنّهم يجمعون هذه الأعضاء المقطعة ، والجسوم المضرّجة ، فيوارونها وينصبون بهذه الطف علماً لقبر أبيك سيد الشهداء ، لا يدرس أثره ، ولا يمحى رسمه على كرور الليالي والأيام ، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلال في محوه وتطميسه ، فلا
__________________
(١٦٥) ـ الأمين ، السيد محسن : أعيان الشيعة ، ج ١ / ١٢٧.
(١٦٦) ـ النوري ، ميرزا حسين الطبرسي : مستدرك الوسائل ، ج ١٠ / ٢١٦ ـ ٢١٧ (باب ١٩ من أبواب المزار ـ حديث ٣).
يزداد أثره إلا ظهورا ، وأمره إلا علواً)(١٦٧) . وبعد التسليم بأنّ بني أسد هم الذين بنوا القبر ،هناك سؤال يطرح : على أي كيفية بنو القبر ؟
الجواب يتضح فيما يلي :
أ ـ قيل : إنهم وضعوا على القبور الرسوم التي لا تبلى ، ولعل هذه الرسوم كانت من لوائح الفخار التي عرفتها المنطقة من العهود الغابرة ، أو من الصخور الكلسية التي كانت متوفرة في تلك المنطقة.
ب ـ وقيل : إنّ بني أسد حددوا له مسجداً ، وبنوا على قبره الشريف سقيفة(١٦٨) .
٢ ـ «وذهب صاحب (كنز المصائب) : إلى أنّ المختار بن أبي عبيدة الثقفي ، هو الذي قام بتشييد البناء على القبر واتخذ قرية من حوله»(١٦٩) ، وقد إعتمد هذا القول مجموعة من الكتّاب والباحثين(١٧٠) ، وخلاصة ما ذكروه ما يلي : عندما إستولى المختار بن أبي عبيدة على الكوفة عام ٦٦ هـ ، بنى على قبره الشريف قبة من الجص والآجر ، واتخذ قرية من حوله ، وكان للمرقد بابان : شرقي وغربي ، وقد تولى ذلك محمد بن إبراهيم بن مالك الأشتر. ولم يزل هذا البناء ـ على ما قيل ـ : حتى عهد هارون الرشيد ـ أي في عام ١٩٣ هـ ، حيث خَرّبه وقطع السدرة التي كانت نابتة عنده ، وكرب موضع القبر(١٧١) . ولعلّ هذا البناء هو الذي أشار إليه الإمام الصادق عليه السلام في رواية صفوان الجمّال : (إذا أردت قبر الحسين عليه السلام في كربلاء ؛ قف خارج القبة وارمِ بطرفك نحو القبر ، ثم
__________________
(١٦٧) ـ ابن قولويه ، الشيخ جعفر بن محمد : كامل الزيارات / ٤٤٥ (باب ٨٨).
(١٦٨) ـ الكرباسي ، الشيخ محمد صادق : دائرة المعارف الحسينية (تاريخ المراقد ، ج ١ / ٢٤٨).
(١٦٩) ـ الكليدار ، الدكتور السيد عبد الجواد : تاريخ كربلاء وحائر الحسين / ١٦٠.
(١٧٠) ـ الكرباسي ، الشيخ محمد صادق : دائرة المعارف الحسينية (تاريخ المراقد ـ ج ١ / ٢٥٠ ـ ٢٥٣ (بتصرف).
(١٧١) ـ نفس المصدر.
أدخل الروضة وقم بحذائها من حيث يلي الرأس ، ثم أخرج من الباب الذي عند رجلي علي بن الحسين عليه السلام ، ثم توجه إلى الشهداء ، ثم إمش حتى تأتي مشهد أبي الفضل العباس ، فقف على باب السقيفة وسلّم)(١٧٢) .
وبعد عرض أهم الأقوال في بناء الحائر ، يهمنا الحديث عن هيئة الحائر في الروايات وفي العصر الحاضر كالتالي :
هندسة الحائر في الروايات :
تتكون الروضة الحسينية من سقيفة على قبر الحسين عليه السلام وابنه علي الأكبر عليه السلام ، وفوقها قبة ولها بابان :
أحدهما ـ باب القبة : وهو من جهة الرأس ، وإلى هذا أشارت رواية صفوان عن الصادق عليه السلام : (... ثم تأتي باب القبة وقف من حيث يلي الرأس)(١٧٣) ، وأيضاً رواية صفوان الأخرى : (... فإذا أتيت الباب فقف خارج القبة وأومِ بطرف نحو القبر ، ـ إلى أن يقول ـ : ثم أدخل رجلك اليمنى القبة وأخّر اليسرى)(١٧٤) .
ثانيهما ـ الباب الذي عند رجلي علي بن الحسين (عليهما السلام) : المقابل إلى الشهداء ، وإلى هذا أشارت رواية صفوان عن الصادق عليه السلام : (ثم أخرج من الباب الذي عند رجلي علي بن الحسين (عليهما السلام) ، ثم تَوجه إلى الشهداء)(١٧٥) . كما تشمل هذا الروضة مرقد الشهداء والمسجد. ويحوط هذه الروضة سور الحائر وله بابان :
__________________
(١٧٢) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٩٨ / ٢٥٩.
(١٧٣) ـ نفس المصدر / ١٩٩.
(١٧٤) ـ نفس المصدر / ٢٥٩.
(١٧٥) ـ نفس المصدر / ٢٠١.
الأول ـ وهو المدخل الرئيسي :
وهو من جهة الشرق ، وهو المقابل لمشهد العباس عليه السلام ، وإلى هذا أشارت رواية يوسف الكناسي عن الصادق عليه السلام : (إذا أتيت قبر الحسين عليه السلام ؛ فأت الفرات واغتسل بحيال قبره ، وتوجه إليه وعليك السكينة والوقار ، حتى تدخل الحير من جانبه الشرقي)(١٧٦) . وكذلك رواية أبي حمزة الثمالي عن الصادق : (... فإذا اتيت الباب الذي بالمشرق ؛ فقف على الباب)(١٧٧) . ويسمى بباب الحائر أيضاً ، كما أشارت إلى ذلك رواية صفوان عن الصادق عليه السلام : (فإذا أتيت باب الحائر ؛ فقف ...)(١٧٨) .
الثاني ـ باب القبلة :
الواقع في الجهة الجنوبية. وبالقرب من هذا المشهد سدرة عالية(١٧٩) ـ في الجهة الشمالية الغربية ـ التي قطها الرشيد ، وإلى هذا تشير رواية يحيى بن المغيرة الرازي قال : (كنت عند جرير بن عبد الحميد(١٨٠) ، إذ جاءه رجل من أهل العراق ، فسأله جرير عن خبر الناس فقال : تركت الرشيد وقد كَرّبَ قبر الحسين عليه السلام ، وأمر أن تقطع السدرة التي فيه فقطعت. قال : فرفع جرير يديه
__________________
(١٧٦) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٩٨ / ١٥٧.
(١٧٧) ـ نفس المصدر / ١٧٧.
(١٧٨) ـ نفس المصدر / ١٩٨.
(١٧٩) ـ ذكر الخليلي في (موسوعة العتبات المقدسة ـ قسم كربلاء : ٢٥٧) ، نقلاً عن كتاب (شيعة الهند : ٦٤) للدكتور جون هوليستر : «إن إحدى الروايات الشيعية تنص على أن بعض المؤمنين المحبين لآل البيت ، كان قد أشّرَ على مكان القبر المطهر بزرع شجرة (عنجاص) باقرب منه ، لكن هذه الشجرة قد اجتثت فيما بعد بأمر من الخليفة هارون الرشيد ، وحرثت الأرض المحيطة بها».
(١٨٠) ـ جرير بن عبد الحميد ، بن قُرْط ، الظّبيُّ ، الكوفي ، نزيل الرّي وقاضيها : ثقة صحيح الكِتاب ، توفي سنة ١٨٨ هـ. راجع تقريب التهذيب ٧٨١.
وقال : الله أكبر ، جاءنا فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : لعن الله قاطع السدرة ثلاثاً ، فلم نقف على معناه حتى الآن ؛ لأنّ القصد بقطعة تغيير مصرع الحسين عليه السلام حتى لا يقف الناس على قبره)(١٨١) .
كما أنّ لهذا المشهد الطاهر سدنة معينون بوظائف مختلفة لخدمته ، وكانوا يتقاضون مرتباتهم من الأوقاف التي كانت قد أسستها أم موسى(١٨٢) ـ أم الخليفة المهدي ـ لهذا الغرض ، وإلى هذا تشير رواية الطبري في حوادث عام ١٩٣ هـ على عهد الرشيد : «ذكر علي بن محمد ، عن عبد الله قال : أخبرني القاسم بن يحيى ، قال بعث الرشيد إلى ابن داود ، والذين يخدمون قبر الحسين في الحير ، قال : فأتى بهم فنظر إليه الحسن بن راشد(١٨٣) وقال : مالك؟ قال : بعث هذا الرجل ـ يعني الرشيد ـ فأحضرني ولست آمنه على نفسي. قال : إذا دخلت عليه فسألك فقل له الحسن بن راشد وضعني في ذلك الوضع. فلما دخل عليه قال هذا القول. قال : ما أخلق أن يكون هذا من تخليط الحسن احضروه. فلما حضر قال : ما حملك على أن صيّرت هذا الرجل في الحير؟ قال : رحم الله من صيّره في الحير ، أمرتني أم موسى أن أصيره فيه ، وأن أجري عليه في كل شهر ثلاثين درهماً ، فقال : ردوه إلى الحير ، وأجروا عليه ما أجرته أم موسى»(١٨٤) .
__________________
(١٨١) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٤٥ / ٤٩٨.
(١٨٢) ـ أم موسى ، هي كنيتها ، وأسمها أروى بنت منصور بن عبد الله بن ذي سهم بن يزيد بن منصور الحميري من ملوك اليمن ، زوجة المنصور العباسي ، توفيت عام ١٤٦.
(١٨٣) ـ مولى بني العباس ، وكان وزير المهدي ، وموسى ، وهارون ، بغدادي.
(١٨٤) ـ الكليدار ، الدكتور السيد عبد الجواد : تاريخ كربلاء وحائر الحسين / ٣٢ ـ ٣٣.
هندسة الحائر في العصر الحاضر :
تتكون العمارة الحالية من صحن واسع تصل مساحته إلى (١٥٠٠٠ م ٢) ، يتوسطه حرم تبلغ مساحته (٣٨٥٠ م ٢) يقع فيه الضريح المقدس ، وتحيط به أروقة بمساحة (٦٠٠ م ٢). وأهم معالم هذا البناء ما يلي :
١ ـ الضريح الحسيني :
يقع الضريح المقدس الذي ضم الجسد الطاهر للإمام الحسين عليه السلام ، مع ابنيه علي الأكبر وعلي الأصغر (الرضيع) عليه السلام ، تحت صندوق من الخشب الساج المرصّع بالعاج الفاخر ، ويحيط به صندوق آخر من الزجاج ، ويعلو الصندوق شباك مصنوع من الفضّة الخالصة موشّى بالذهب ، وتحيط بالشبّاك روضة واسعة فرشت أرضها بالمرمر الإيطالي ، وغُلّفت جدرانها بارتفاع مترين بالمرمر نفسه ، فيما تزدان بقية الجدران والسقوف بالمرايا التي صنعت بأشكال هندسيّة ، تشكل آية من آيات الفن المعماري الرائع ، وهو ذو أربعة أركان ، وفي جانب الطول الذي حول قبر الحسين عليه السلام خمسة أقسام معلومة ، وفي العرض أربعة أقسام ، عرض القسم الواحد مها (٨٠ سم) بينما مشبك علي الأكبر في عرضه شباك واحد ، وفي طوله شباكان ، طول مشبك الحسين عليه السلام (٥,٥ م) ، وعرضه (٤,٥ م) ، أما طول مشبك علي الأكبر (٢,٦ م) وعرضه (١,٤٠ م). وترتفع فوق الصندوق من جهاته الأربعة رمانات ذهبية ، يبلغ قطر كل منها (٥٠ سم) ، وإلى جانب الرمانات (٦ آوانٍ) مستطيلة الشكل مطلية بالذهب ، يبلغ طولها حوالي نصف متر.
٢ ـ القبة الذهبية :
وتعلو المرقد الحسيني قبة شاهقة بارتفاع (٣٧ م) من الأرض ، تتربع أربع دعامات ضخمة مستطيلة (٣,٥ م × ٢,٥ م) ، والقبة بصلية الشكل ، ذات رقبة طويلة تتخللها عشرة شبابيك ، يبلغ عرض كل منها (١,٣٠ م) ، وبين كل شباك وآخر مسافة (١,٥٥ م) ، وهي مغشاة من أسفلها إلى أعلاها بالذهب الخالص ، ويبلغ عدد الطابوق الذهبي الذي يغطيها (٨٠٢٤) طابوقة ، ومساحة القبة تبلغ (٣٠١ م ٢) ذهب ، وتعلو قمتها سارية من الذهب الخالص بطول (٢ م) ، وتحف بالقبة مئذنتان مطليتان بالذهب.
٣ ـ ضريح الشهداء :
وموقعه قريب من الضريح الحسيني إلى جهة الشرق ، يفصل بينه وبين ضريح علي الأكبر مقدار (١,٥ م) ، وفي واجهة المرقد شباك فضي طوله (٤.٨٠ م) ، والثاني فتح حديثاً ؛ وهو يطل على الرواق الجنوبي إلى اليمين من باب القبلة.
٤ ـ الأروقة :
يحيط بالحرم الحسيني أربعة أروقة ، من كل جهة رواق ، يبلغ عرض الرواق الواحد (٥ م) ، وطول ضلع كل من الرواق الشمالي الجنوبي (٤٠ م) تقريباً ، وطول ضلع كل من الرواق الشرقي الغربي (٤٥ م) تقريباً. وأرضيتها جميعاً مفروشة بالرخام الأبيض الناصع ، وفي وسط جدرانها كلها قطع من المرايا الكبيرة أو الصغيرة ، ويبلغ ارتفاع كل رواق (١٢ م) ولكل رواق من هذه الأروقة اسم خاص به كالتالي :
الرواق الغربي :
ويدعى برواق السيد إبراهيم المجاب ، نسبة إلى مدفن السيد إبراهيم ، بن محمد العابد ، بن الإمام موسى الكاظم عليه السلام ، وسمي بالمجاب لحادثة مشهورة ـ وهي : أنه سَلّم على جده الحسين عليه السلام ، فأجيب من القبر ـ ، وقد قدم كربلاء سنة (٢٤٧ هـ) واستوطنها إلى وفاته ، وفن في هذا الموضع ، وعليه اليوم ضريح من البرونز ، وتمر به الزوار لزيارته.
الرواق الجنوبي :
ويدعى برواق حبيب بن مظاهر الأسدي ، نسبة إلى وجود قبر الشهيد حبيب بن مظاهر الأسدي ، وعلى قبره اليوم ضريح من الفضة.
الرواق الشرقي :
ويدعى برواق الفقهاء ، وفيه مدافن شخصيات العلمية الكبيرة.
الرواق الشمالي :
ويدعى برواق الملوك ، حيث إحتوى على مقبرة للملوك القاجاريين.
٥ ـ أبواب الأروقة الداخلية :
توجد ثمانية أبواب داخلية للأروقة تؤدي إلى ال حضرة المطهرة ، وهي : باب القبلة ، باب علي الأكبر ، باب الكرامة ، باب الناصري ، باب السيد إبراهيم المجاب ، باب رأس الحسين ، باب حبيب بن مظاهر ، باب صاحب الزمان.
٦ ـ المذبح :
وهو المحل الذي ذبح فيه الإمام الحسين عليه السلام ، وموضعه إلى الجنوب الغربي من الرواق ، ويتألف من غرفة خاص لها باب فضي ، وأرضيتها من
المرمر الناصع ، وفيها سرداب يعلوه باب فضي أيضاً ، ويطل على هذه الغرفة شباك على الصحن من الخارج.
٧ ـ الصحن :
وهو بناء كبير وفناء واسع يحيط بالمرقد الشريف ، ويطلق عليه البعض إسم الجامع ؛ لإجتماع الناس فيه لإقامة الصلوات الخمس ، وأداء الزيارات المخصوصة في مواسمها المعلومة. والصحن من الداخل على شكل مستطيل ولكنه سداسي على شكل الضريح المقدس ، ويحيط به سور عالٍ يفصل الروضة من الخارج ، وجرى تزيينه بالطابوق الأصفر والقاشي ، وكتبت عليه من الجهة العليا الآيات القرآنية الكريمة بالخط الكوفي البديع ، ومن الداخل تتوزعه الإيوانات التي بلغ عددها (٦٥) إيواناً ، تطل على الصحن وتحيطه من جميع جوانبه ، وفي كل إيوان وجد حجرة مزيّنة جدرانها بالفسيفساء.
٨ ـ أبواب الصحن :
للصحن الشريف عشرة أبواب يؤدي كل منها إلى الشارع الدائري ، المحيط بالروضة والشوارع المتفرعة منه ، وقد جاءت كثرة هذه الأبواب ، من أجل تخفيف حدى الزحام في مواسم الزيارات ، وجميع الأبواب مصنوعة من الخشب الساج وبأشكال بديعة ، وعليها سقوف مُغلّفة بالقاشاني ، وتتضمن حواشيها الآيات القرآنية الكريمة ، والأبواب هي :
باب القبلة : وهو من أقدم الأبواب ، ويُعدّ المدخل الرئيسي إلى الروضة الحسينية ، وعرف بهذا الاسم لوقوعه إلى جهة القبلة ، ويبلغ ارتفاع قوس البرج من مدخل الصحن حوالي (١٥ م) ، وعرض قاعدته (٨ م) ، أما الباب الجديد ؛
فهو مصنوع من الخشب الساج الفاخر ، مُطعّم بخشب النارنج ، ويبلغ ارتفاعه حوالي (٦ م) ، وعرض قاعدته (٤ م).
باب الرجاء : يقع بين باب القبلة وباب قاضي الحاجات ، ويبلغ ارتفاعه حوالي (٥ م وعرضه (٣,٥ م).
باب قاضي الحاجات : يقع هذا الباب مقابل سوق التجار (العرب) ، وقد عرف بهذا الاسم نسبة إلى الإمام الحجة المهدي (عج) ، ويبلغ ارتفاع الباب حوالي (٥ م) وعرضها (٣,٥ م).
باب الشهداء : يقع هذا الباب في منتصف جهة الشرق ، حيث يتجه الزائر منه إلى مشهد العباس عليه السلام ، وعرف بهذا الاسم تيمناً بشهداء معركة الطف ، يبلغ ارتفاعه (٤ م) وعرضه (٣ م).
باب الكرامة : يقع هذا الباب من أقصى الشمال الشرقي من الصحن ، وهو مجاور لباب الشهداء ، وعرف بهذا الإسم كرامة للإمام الحسين عليه السلام ، يبلغ ارتفاعه (٤ م) وعرضه (٣ م).
باب السلام : يقع في منتصف جهة الشمال ، وعرف بهذا الإسم ؛ لأن الزوار كانوا يسلمون على الإمام عليه السلام بإتجاه هذا الباب ، ويبلغ ارتفاعه (٤ م) وعرضه (٣ م).
باب السدرة : يقع هذا الباب في أقصى الشمال الغربي من الصحن ، وعرف بهذا الإسم تيمناً بشجرة السدرة ، التي كان يستدل بها الزائرون في القرن الأول الهجري ، إلى موضع قبر الحسين عليه السلام ، ويقابل هذا الباب شارع السدرة ، يبلغ ارتفاعه (٤ م) وعرضه (٣ م).
باب السلطانية : يقع هذا الباب غرب الصحن الشريف ، وعرف بهذا الإسم نسبةً إلى مشيّده أحد سلاطين آل عثمان ، يبلغ ارتفاعه (٤ م) وعرضه (٣ م).
باب الرأس الشريف : يقع هذا الباب في منتصف جهة الغرب من الصحن الشريف ، وعرف بهذا الإسم ؛ لأنّه يقابل موضع رأس الحسين عليه السلام ، يبلغ ارتفاعه (٤ م) وعرضه (٣ م) ، ونصبت الساعة فوق هذا الباب.
باب الزينبية : يقع هذا الباب إلى الجنوب الغربي من الصحن ، وقد سمي بهذا الإسم تيمناً بمقام الزينبية المقابل له ، ويبلغ ارتفاعه (٤ م) وعرضه (٣ م).
٩ ـ الطّارْمة : (إيوان الذهب) :
يطل هذا الإيوان على الصحن الضريف من جهة الجنوب ، وله سقف عالٍ ولكنه ليس بمستوى واحد ، فهو مرتفع من الوسط ومنخفض من ال طرفين ، ويرتكز السقف على أعمدة من الرخام الفاخر ، والإيوان مستطيل الشكل بطول (٣٦ م) وعرض (١٠ م) ، وقد كسيت جدرانه بالذهب الخالص ، وزُيِّنت جوانبه بالفسيفساء المنقوشة بشكل بديع ، بينما بقية الجدران كسيت بالقاشاني المزخرف ، ويفصل هذا الإيوان عن الصحن مُشَبّك معدني ، ويكون المرور من الجانبين إلى الروضة.
١٠ ـ خزانة الروضة الحسينية :
وتقع في الواجهة الشمالية للروضة ، وهي غرفة حصينة تضم هدايا الملوك والسلاطين والأمراء والشخصيات الكبيرة من مختلف البلدان الإسلامية ، وفيها تحف نادرة ونفائس باهرة.
١١ ـ مكتبة الروضة الحسينية :
وتقع إلى الجهة اليمنى عند مدخل باب القبلة ، وتأريخ تأسيسها يعود إلى سنة ١٣٩٩ هـ ، وهي تضم العديد من الكتب المطبوعة والمخطوطة ، بالإضافة إلى المصاحف المخطوطة الثمينة(١٨٥) .
ب ـ مبدأ تسميتها بالحائر أو الحير :
لم يرد في التاريخ أو الحديث أي ذكر لهذه البقعة المقدسة بإسم الحائر أو الحير قبل إستشهاد الحسين عليه السلام ؛ إذ الأحاديث النبوية المنبأة بقتل الحسين عليه السلام تضمنت عدة أسماء ولم يكن من بينها الحائر أو الحير ، وكذلك بعد عصر النبوة إلى عصر الإمام زين العابدين عليه السلام ، ولكن أول ذكر لهذا الإسم كان على لسان الباقر عليه السلام ، فيستدل من ذلك أنّ اسم الحائر أو الحير لم يكن قديماً ، بل هو اسم حدث في عصر الإمام الباقر عليه السلام. وهذا ما يدعو إلى التساؤل عن سبب ظهوره في مثل هذا العصر بالخصوص؟
لعل من أهم الأسباب في ذلك ، تلك الظروف الحرجة في العصر الأموي ، وحفاظاً على ذلك المعلم الحسيني الشامخ ، وحفاظاً على زواره الكرام ، ما ذكر إلا على نحو السرية في هذا العصر ، ولما سنحت الفرصة لإبنه الإمام الصادق عليه السلام في نهاية الدولة الأموية ، صرّح بهذه التسمية.
وخلاصة ما توصلنا إليه : إنّ إطلاق هذا الإسم على هذه البقعة الشريفة بعد أنّ تمصرت وأصبحت ذات شأن ، ومحطاً للتجارة والقوافل ، نظراً لأهمية موقعها الديني ، ولوقوعها بين المناطق الغنية بالمحاصيل الزراعية ، ومن الشواهد
__________________
(١٨٥) ـ آل طعمة ، السيد سلمان هادي : دليل كربلاء المقدسة / ١٧ ـ ٢٦. تاريخ مرقد الحسين والعباس / ٩٧ ـ ١٩١. (بتصرف).
على ذلك ما رواه سبط ابن الجوزي ، عن السدي بأنه قال : «نزلت بكربلاء ومعي طعام للتجارة ، فنزلنا على رجل : فتعشينا عنده ، وتذاكرنا قتل الحسين عليه السلام وقلنا : ما شرك أحد في دم الحسين إلا ومات أقبح موته. فقال الرجل ما أكذبكم ، أنا شركت في دمه ، وكنت فيمن قتله ، وما أصابني شيء. فلما كان آخر الليل إذا بصياح! قلنا : ما الخبر؟ قالوا : قام الرجل يصلح المصباح فاحترقت اصبعه ، ثم دَبّ الحريق في جسده فاحترق. قال السدي : فأنا والله رأيته كأنه حممه»(١٨٦) .
وهذا الخبر صريح في أنّ كربلاء بعد واقعة الطف صارت آهله بالسكان ، كما أنّها نالت شهرة واسعة ؛ حيث أقبل الناس على زيارتها من كل حدب وصوب ، وأن القبر الشريف يقصده الناس للزيارة وقضاء الحوائج ، ويظهر منه المعجز الباهر ، ومن الشواهد على ذلك : «ما ورد في نوادر علي بن أسباط ، عن غير واحد من أصحابه قال : لما بلغ أهل البلدان شهادة أبي عبد الله عليه السلام ؛ قدمت كل إمرأة نزور ـ وكانت العرب تقول للمرأة التي لا تلد أبداً إلا أن تخطّى قبر رجل كريم النزور ـ التي لا تلد أبداً ، إلا أن تخطّى قبر رجل كريم ، فلما قيل للناس : إنّ الحسين ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد وقع ؛ أتته مائة ألف إمرأة لا تلد ، فولدن كلهن»(١٨٧) .
١٧ ـ حرم الحسين (عليه السلام) :
ذكرت الروايات أن للقبر الشريف حرمة ، تبدأ من دائرة صغيرة حول القبر الشريف ، وتتسع حتى تبلغ دائرة أوسع ، حتى تشمل مدينة كربلاء ،
__________________
(١٨٦) ـ الكليدار ، الدكتور السيد عبد الجواد : تاريخ كربلاء وحائر الحسين / ٧٦.
(١٨٧) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٩٨ / ٧٥.
وحددتها الروايات بعشرين ذراعاً ، وخمسة وعشرين ذراعاً ، وفرسخ ، وأربعة فراسخ ، وخمسة فراسخ ، من جوانب القبر الشريف ، فعلى هذا تأتي قاعدة الشرفية بين هذه الحدود المذكورة ، على ترتيب المواضع حسب قاعدة الأقرب فالأقرب إلى القبر الشريف ، والذي نريد بحثه هو التالي :
أولاً ـ عرض الروايات :
١ ـ حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : (من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن : حرم الله ، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وحرم أمير المؤمنين عليه السلام ، وحرم الحسين بن علي عليهما السلام) (١٨٨).
٢ ـ عبد الحميد ـ خادم إسماعيل بن جعفر ـ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (تتم الصلاة في أربعة مواطن : المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين عليه السلام) (١٨٩).
٣ ـ حذيفة بن منصور ، عمن سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : (تتم الصلاة في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين عليه السلام) (١٩٠).
٤ ـ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : (تتم الصلاة في أربعة مواطن : في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين عليه السلام) (١٩١).
__________________
(١٨٨) ـ الحر العاملي ، الشيخ محمد الحسن : وسائل الشيعة ، ج ٥ / ٥٤٣ (باب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر ، حديث ١).
(١٨٩) ـ نفس المصدر / ٥٤٦ (الحديث ١٤).
(١٩٠) ـ نفس المصدر / ٥٤٨ (الحديث ٢٣).
(١٩١) ـ نفس المصدر / ٥٤٩ (الحديث ٢٥).
ثانياً ـ ما المراد بالحرم الحسيني؟
قال المحقق الفقيه السيد الخوئي (قده) : «وحيث أنّ لفظ الحرم ليس له وضع شرعي ولا تشرعي ، بل هو مأخوذ من الحريم بمعنى الإحترام ، فالمراد به في المقام يتردد بين أمور :
أحدها ـ أن يراد به كربلاء بتمامها ، كما كان كذلك في حرم الله ، وحرم رسوله ، وحرم أمير المؤمنين عليه السلام ، على ما عرفت ، فإنّ قدسية الحسين العظيمة ، وشرافته تقتضي ذلك كما لا يخفى(١٩٢) .
ثانيهما ـ أن يكون أخص من ذلك ، وهو الصحن الشريف. وما يحتوي عليه ، كما ذهب إليه جماعة ، منهم العلامة المجلسي (قده) ، باعتبار أن من يرد الصحن الشريف حتى من أهالي كربلاء ؛ يرى أن لهذا المكان المقدس إحتراماً خاصاً لا يشاركه خارج الصحن ، ولأجله لا يرتكب بعض الأفعال التي لا تناسب المقام ، من ضحك كثير أو لعب ونحو ذلك.
ثالثهما ـ أن يكون أضيق من ذلك أيضاً ، بأن يراد به الرواق وما حواه من الحرم الشريف ، فإنّ الإحترام هناك آكد ، ومناط للتجليل أزيد ؛ ولذا لا يرتكب فيه ما قد يرتكب في الصحن الشريف.
رابعهما ـ أن يراد به الأضيق من الكل ؛ وهو ما دار عليه سور الحرم ، والمُعَبّر عنه باسم الحرم في عصرنا الحاضر ، فإنّ هذا المكان الشريف هو الفرد
__________________
(١٩٢) ـ ذكر الشهيد الأول (قده) في ذكرى الشيعة ، ج ٤ / ٢٩١ ـ ٢٩٢ ما يلي :
«والشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد ـ في كتاب السفر له ـ حكم بالتخيير في البلدان الأربعة حتى في الحائر المقدس ، لورود الحديث بحرم الحسين (ع) ، وقُدِّر بخمسة فراسخ ، وبأربعة فراسخ. قال : والكل حرم وإن تفاوتت في الفضيلة».
البارز ، وأظهر المصاديق مما يطلق عليه لفظ الحرم ، فهو القدر المتيقن مما يراد من هذا اللفظ عند الإطلاق ، فإذا دار الأمر بين هذه المحتملات ؛ فمقتضى الصناعة الإقتصار على المقدار المتيقن لدى تردد المخصص المجمل ، بين الأقل والأكثر وهو المعنى الأخير ، والرجوع فيما عداه إلى عمومات القصر التي هي المرجع ما لم يثبت التخصيص بدليل قاطع»(١٩٣) .
أقول : هذا هو القول المشهور. وحمل الحرم في تلك الروايات على الحائر ، باعتبار أنّه أخص أفراد الحرم وأشرفها ، ويؤيد ذلك الروايات الدالة على أنّه عند القبر ، فإنّ إطلاق العندية على البلد لا يخلو من البعد ، وأقرب مصاديقه الحائر ؛ إذ في مقام الجمع بين الروايات القدر المتيقن هو ذلك.
ثالثاً ـ حدود الحرم الحسيني :
قال الفقيه المحقق السيد السبزواري (قده) : «وأما التحديدات الواردة في حدّ حرم الحسين (عليه السلام) ـ كما في خبر منصور بن العباس ـ أنه خمسة فراسخ من أربع جوانبه ، وفي مرسل البصري : أنه فرسخ في فرسخ من أربع جوانب القبر ؛ فهي من جهة التبرك وأخذ التربة الشريفة ، ولا ربط لها في المقام ، فراجع»(١٩٤) .
أقول : ويؤيد ذلك الروايات التالية :
١ ـ إنّ أبا حمزة الثمالي قال للصادق عليه السلام : (إني رأيت اصحابنا يأخذون من طين قبر الحسين عليه السلام ليستشفوا به ، فهل ترى في ذلك
__________________
(١٩٣) ـ البروجردي ، العلامة الحجة الشيخ مرتضى : مستند العروة الوثقى ، ج ٨ / ٤١٩ ـ ٤٢٠.
(١٩٤) ـ السبزواري ، السيد عبد الأعلى : مهذب الأحكام ، ج ٩ / ٣٠٤.
شيئاً مما يقولون من الشفاء؟ فقال : يستشفي بما بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال)(١٩٥) .
٢ ـ روي (أنّ الحسين عليه السلام إشترى النواحي التي فيها قبره من أهل نينوى ، والغاضرية بستين ألف درهم ، وتصدق عليهم ، وشرط أن يرشدوا إلى قبره ، ويضيفوا من زاره ثلاثة أيام)(١٩٦) .
٣ ـ وقال الصادق عليه السلام : (حرم الحسين الذي اشتراه أربعة أميال في أربعة أميال ، فهو حلال لولده ومواليه ، حرام على غيرهم ممن خالفهم وفيه البركة)(١٩٧) .
«ذكر السيد الجليل رضي الدين ، علي بن طاووس رحمه الله : إنها إنما صارت حلالاً بعد الصدقة ؛ أنهم لم يفوا بالشرط»(١٩٨) .
٤ ـ عن سليمان بن عمرو السراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : (يؤخذ طين قبر الحسين عليه السلام ، من عند القبر على سبعين ذراعاً)(١٩٩) .
٥ ـ محمد بن عيسى ، بالإسناد عنه (عليه السلام) قال : (يؤخذ طين قبر الحسين (عليه السلام) من عند القبر على سبعين ذراعاً في سبعين باعاً)(٢٠٠) .
٦ ـ عن أبي الصباح ، الكناني ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : (طين قبر الحسين عليه السلام فيه الشفاء ، وإن أُخذ على رأس ميل)(٢٠١) .
__________________
(١٩٥) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٩٠ / ٣٠٤.
(١٩٦) ـ النوري ، ميرزا حسين الطبرسي : مستدرك الوسائل ، ج ١٠ / ٣٣٢ ، (باب ٥٣ من أبواب المزار ـ حديث ٩).
(١٩٧) ـ البهائي ، الشيخ بهاء الدين بن الشيخ عبد الصمد : الكشكول ، ج ٢ / ١٦.
(١٩٨) ـ نفس المصدر.
(١٩٩) ـ النوري ، ميرزا حسين الطبرسي : مستدرك الوسائل ، ج ١٠ / ٣٣٣ ، (باب ٥٣ من أبواب المززار ـ حديث ١٠).
(٢٠٠) ـ نفس المصدر / ٣٣٤ ، (الحديث ١١).
(٢٠١) ـ نفس المصدر ، ج ١٠ / ٣٣١ ، (باب ٥٣ من أبواب المزار ـ حديث ٤).
٧ ـ عن الحجّال ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (التربة [البركة خ ل] من قبر الحسين بن علي عليه السلام ، على عشرة أميال) (٢٠٢).
وبعد عرض هذه الروايات ؛ نستتنتج التالي :
١ ـ قال شيخ الطائفة الطوسي (قده) : «والوجه في هذه الأخبار ، ترتب هذه المواضع في الفضل ، فالأقصى خمس فراسخ ، وأدناه في المشهد فرسخ ، وأشرف الفرسخ ، خمس وعشرون ذراعاً ، وأشرف الخمس وعشرين ذراعاً ، عشرون ذرعاً ، وأشرف العشرين ما شرف به ، وهو الجدث نفسه»(٢٠٣) .
وقال أيضاً : «وليس في هذه الأخبار تناقض ولا تضاد ، وإنما وردت على الترتيب في الفضل ، وكان الخبر الأول غاية فيمن يُجوِّز ثواب المشهد ، إذا حصل فيما بينه وبين القبر على خمسة فراسخ ، ثم الذي يزيد عليه في الفضل ، من حصل على فرسخ ، ثم الذي حصل على خمسة وعشرين ذراعاً ، ثم من حصل على عشرين ذراعاً ، وإن كان المراد بها ما ذكرناه لم تتناقض ولم تتضاد ، والذي يدل على أنّ المراد بهذه الأخبار ، ما أشرنا إليه من الفضل والبركة»(٢٠٤) .
٢ ـ إنّ الحدود التي ذكرتها الروايات للحرم الحسيني الشريف هي : (عشرون ذراعاً ، وخمسة وعشرون ذراعاً ، وسبعون ذراعاً ، وسبعون باعاً ، وميل ، وأربعة أميال ، وعشرة أميال ، وفرسخ ، وأربعة فراسخ ، وخمسة فراسخ).
٣ ـ يمكن حسابها بالأمتار والكيلومترات كما يلي :
__________________
(٢٠٢) ـ الحر العاملي ، الشيخ محمد بن الحسن : وسائل الشيعة ، ج ١٠ / ٤٠١ (باب ٦٧ من أبواب المزار ـ حديث ٧).
(٢٠٣) ـ الطوسي ، الشيخ محمد بن الحسن : مصباح المتهجد / ٥٠٩.
(٢٠٤) ـ الطوسي ، الشيخ محمد الحسن : تهذيب الأحكام ، ج ٦ / ٧٢ (باب ٢٢ من أبواب المزار).
الذراع = ٤٨ سم ، والباع = ٤ أذرع ، والميل = ٤٠٠٠ ذراع ، والفرسخ = ١٢٠٠٠ ذراع. فتكون النتيجة كما هي موضحة فيا لجدول التالي :
الحد في الروايات |
بالذراع |
بالامتار والكيلومترات |
عشرون ذراعاً |
/ |
٩,٦٠ م |
خمسة وعشرون ذراعاً |
/ |
١٢ م |
سبعون ذراعاً |
/ |
٣٣,٦٠ م |
سبعون باعاً |
٢٨٠ |
١٣٤,٤٠ م |
ميل |
٤٠٠٠ |
١,٩٢٠ كم |
أربعة أميال |
١٦٠٠٠ |
٧,٦٧٠ كم |
عشرة أميال |
٤٠٠٠٠ |
١٩,٢٠٠ كم |
فرسخ |
١٢٠٠٠ |
٥,٧٦٠ كم |
أربعة فراسخ |
٤٨٠٠٠ |
٢٣,٤٠ كم |
خمسة فراسخ |
٦٠٠٠٠ |
٢٨,٨٠٠ كم |
وعلى هذا تكون مساحة الحرم الحسيني المقدرة ب(٢٨,٨٠٠,٠٠٠ كم × ٢٨,٨٠٠,٠٠٠ كم) = ٨٢٩,٤٤ كم ٢ ، «وأما مساحة محافظة كربلاء الكلية ؛ فتبلغ (٨٥٩,٥٢ كم ٢). وهي تتألف مما يلي :
١ ـ مركز قضاء كربلاء وتتبعه :
أ ـ ناحية الحر ، ب ـ ناحية الحسينية.
٢ ـ قضاء الهندية وتتبعه :
أ ـ ناحية الخيرات ، ب ـ ناحية الجدول الغربي.
٣ ـ قضاء عين التمر» (٢٠٥) .
رابعاً ـ الفرق بين الحائر والحرم :
من الأمور التي تحتاج إلى إيضاح ، مسألة الفرق بين الحائر والحرم ، فهل هما بمعنى واحد ، أو يختلفان تماماً ، أو يتفقان في بعض الأمور أم لا؟
في الجواب على هذا السؤال نقول : قد يتفقان وقد يختلفان حسب التفصيل التالي :
١ ـ موارد الإتفاق :
إذا أخذنا بالمعنى اللغوي القائل : بأنّ الحائر أو الحير يطلق على كربلاء بشكل عام ؛ فلا فرق بينهما ، وكذلك إذا أخذنا بما ورد في بعض الروايات ، التي إعتمدها الشيخ نجيب الدين ، يحيى بن سعيد ، حيث حكم بالتخيير في البلدان الأربعة حتى في الحائر المقدّس ، وقد تقدم ذكره(٢٠٦) .
وإذا أخذنا بالمعنى اللغوي القائل : إنّ الحير هو ما يشبه الحضيرة والحمى ؛ فهذا ينسجم مع معنى الحرم. وينسجم مع بعض الروايات الناصّة على هذا المعنى ـ كما في رواية إسحاق بن عمّار ـ القائلة : (لموضع قبر الحسين بن علي عليهما السلام حرمة معلومة ، من عرفها واستجار بها أجير. قلت : فصف لي موضعها جعلت فداك. قال إمسح من موضع قبره اليوم ، فامسح خمسة وعشرين ذراعاً من ناحية رجليه إلخ). فبناء على هذه الرواية والرواية القائلة (عند القبر) لا فرق بين الحرم والحائر ؛ لأن المشهور بين الفقهاء ـ كما أشار المحقق السيد الخوئي (قده) ـ بأنّ هذا هو المقدار المتيقن من الحرم والحائر ، الذي هو طريقة
__________________
(٢٠٥) ـ آل طعمة ، السيد سلمان هادي : دليل كربلاء المقدسة / ٧ ـ ١٠ (بتصرف).
(٢٠٦) ـ راجع ص / ١٢٢.
الجمع بين الروايات ، فحمل الحائر ، والحرم ، وعند القبر ، في روايات التخيير على هذه البقعة المحدودة. إذن لا فرق بينهما من هذه الناحية.
٢ ـ موارد الإختلاف :
وإذا أخذنا بالروايات المحددة للحرم ؛ فالحرم أوسع من الحائر ، وهذا التمييز عند الرواة بين الحائر والحرم ، يدل على أنّ هذه المنطقة لها قدسيتها للتبرك ، وأخذ تربتها للإستشفاء ، ولكن هذه المنطقة الواسعة خارجة عن حدود الحائر الذي يرجع إلى مسألة تعبدية محضة ، تدور حول وجوب القصر أو التخيير بين القصر والتمام للزائر المسافر ، وهذا الذي جعل الفقهاء يبحثون في مؤلفاتهم عن حقيقة الحائر وحدوده على ضوء الروايات ، كما أنّ إلتزام الرواة والمححيد الحائر ، وتعيين حدوده بالضبط إلى هذه الدرجة ، فهو لأمر عبادي كي لا يتجاوزوا حدود ما كان عليه الحائر المقدس في زمن الصادق عليه السلام ، حين وردت فيه أخبار التخيير للمصلي بين القصر والتمام.
فالنتيجة التي توصلنا إليها : أنّ الحرم والحائر قد يجتمعان من ناحية القدر المتيقن ، لأفضل بقعة لها قدسيتها ، وما يترتب على ذلك من مسألة التخيير بين القصر والتمام ، وكذلك للتبرك ، وأنها المكان الذي هو محل الإستجارة وإستجابة الدعاء كما ورد في الروايات. وأنّ الحرم إذا استخدم في غير ذلك ؛ فالروايات الكثيرة تستخدم الحرم في الإستشفاء والتبرك ، وأخذ التربة الحسينية ، فيكون معنى الحرم وحدوده أوسع من الحائر أو الحير.
١٨ ـ روضة من رياض الجنة :
نَصّت بعض الروايات على ذكر هذا الإسم كالتالي :
١ ـ عن إسحاق بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : (موضع قبر الحسين بن علي (عليهما السلام) منذ يوم دفن ، روضة من رياض الجنة)(٢٠٧) .
٢ ـ عن عبد الله بن سنان قال : (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قبر الحسين بن علي عليه السلام ، عشرون ذراعاً في عشرين ذراعاً مكسراً ، روضة من رياض الجنة ، منه معراج إلى السماء ، فليس من ملك مقرّب ، ولا نبي مرسل إلا وهو يسأل الله أن يزوره ، وفوج يهبط وفوج يصعد)(٢٠٨) .
٣ ـ عن جابر بن يزيد قال : (خرجت مع أبي جعفر عليه السلام وهو يريد الحيرة ، فلما أشرفنا على كربلاء قال لي : يا جابر ، هذه روضة من رياض الجنة ، لنا ولشيعتنا ، وحفرة من حفر جهنم لأعدائنا)(٢٠٩) .
معنى الروضة :
س / ما المراد بـ(روضة من رياض الجنة)؟
ج / قبل بيان المراد لابد من بيان التالي :
١ ـ الروضة لغة :
قال ابن منظور : «الروضة : الأرض ذات الخضرة ، والروضة : البستان الحسن ، عن ثعلب. وقوله عليه السلام : (بين قبري أو بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة) ؛ الشك من ثعلب فسّره هو وقال : معناه أنه من أقام بهذا الموضع ؛ فكأنه أقام في روضة من رياض الجنة ، يُرَغّب في ذلك ، والجمع من ذلك كله ، رَوْضَات ورِياض ورَوْض»(٢١٠) .
__________________
(٢٠٧) ـ النوري ، ميرزا حسين الطبرسي : مستدرك الوسائل ، ج ١٠ / ٣٢٤ ـ ٣٢٥ ، (باب ٥١ من أبواب المزار ـ حديث ٨).
(٢٠٨) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٩٨ / ١٠٦.
(٢٠٩) ـ البحراني ، السيد هاشم : مدينة المعاجز ، ج ٣ / ١٤٢.
(٢١٠) ـ بن منظور ، محمد بن مكرم : لسان العرب ، ج ٧ / ١٦٢ ـ ١٦٣.
٢ ـ الروضة في القرآن الكريم :
ورد ذكرها في موردين : في قوله تعالى : ( فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ) [الروم ١٥]. قال الشيخ الطوسي (قده) : «وإنما خص ذكر الروضة ـ ههنا ـ لأنّه لم يكن عند العرب شيء أحسن منظراً ، ولا أطيب ريحاً من الرياض ، كما قال الشاعر :
ما رَوْضَةٌ من رياض الحزن مُعْشِبَةٌ |
خَضْرَاءُ جادَ عليها مُسْيلٌ هِطِلُ |
|
يُضاحِكُ الشمسَ منها كوكبٌ شَرِقٌ |
مُؤَزِّرٌ بعميم النّبْتِ مُكْتهِلُ»(٢١١) |
٣ ـ رأي الأعلام في تفسير الروضة :
أهم الوجوه التي قيلت في تفسير الحديث ما يلي :
الأول ـ الشريف الرضي (قده) : «إنّما شبهه بالروضة ، لما يمرّ عليه من محاسن الكلم ، وبدائع الحِكَم التي تشبه أزاهير الرياض ، وديابيج النبات ، ومه يقولون في الكلام الحسن : كأنّه قِكَعُ الروض ، وكأنّه ديباج الرقيم ، وأضاف ـ عليه الصلاة والسلام ـ الروضة إلى الجنة ؛ لأنّه الكلام المُونِق الذي يتكلم به عليه الصلاة والسلام ، يهدي إلى الجنة ويكون دالاً عليها وقائداً إليها ، وعندهم أنّ الروضة إذا كانت على الإيقاع والإنتشار ؛ كانت أحسن منظراً وآنق زهراً»(٢١٢) وإلى هذا ذهب السيد عبد الله شبّر (قده)(٢١٣) ، وقريب منه قول المجلسي الكبير (قده) : «يمكن أن يكون المراد أنها توضع يوم القيامة على باب الجنة ، أو أطلق الجنة على مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجازاً ، فإنّها الجنة التي بنيت فيها
__________________
(٢١١) ـ الطوسي ، الشيخ محمد بن الحسن : التبيان في تفسير القرآن ، ج ٨ / ٢٣٦.
(٢١٢) ـ الشريف الرضي / السيد محمد بن أبي أحمد : المجازات النبوية / ٨٤ ـ ٨٥.
(٢١٣) ـ شبّر ، السيد عبد الله بن السيد محمد رضا : مصابيح الأنوار ، ج ٢ / ٣٠٩.
أشجار المعرفة والمحبة والعبادة ، وسائر الكمالات»(٢١٤) ، وإليه ذهب الشيخ الطريحي (قده)(٢١٥) . والقتيبي(٢١٦) وغيره من علماء العامة. كما ذكر ذلك السمهودي(٢١٧) . ويؤيد هذا القول : أنه قد تقرر في قواعد الشرع ، أنّ البقع المباركة ما فائدة بركتها لنا والإخبار بذلك إلا تميزها بالطاعات ، فقد ورد في الحديث النبوي : (إذا رأيتم روضة من رياض الجنة فارتعوا فيها) قيل : يا رسول الله ، وما روضة الجنة؟ قال : مجالس المؤمنين)(٢١٨) .
وفي الحديث النبوي أيضاً : (بادورا إلى رياض الجنة. فقالوا : وما رياض الجنة؟ قال : حِلَقْ الذكر)(٢١٩) .
وفي عدة الداعي : «روي أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على أصحابه فقال : (إرتعوا في رياض الجنة. قالوا : يا رسول الله ، وما رياض الجنة؟ قال : مجالس الذكر إغدوا وروحوا واذكروا ، ومن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله ؛ فلينظر كيف منزلة الله عنده ، فإنّ الله تعالى ينزل العبد حيث أنزل العبد الله من نفسه ، واعلموا أنّ خير أعمالكم وأزكاها وارفعها في درجاتكم ، وخير ما طلعت عليه الشمس ذكر الله سبحانه ، فإنّه أخبر عن نفسه فقال : أنا جليس من ذكرني ، وقال سبحانه : ( فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ) بنعمتي ، واذكروني بالطاعة والعبادة ، أذكركم بالنعم والإحسان والرحمة والرضوان»(٢٢٠) .
__________________
(٢١٤) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : مرآة العقول ، ج ١٨ / ٢٦٥.
(٢١٥) ـ الطريحي ، الشيخ فخر الدين بن الشيخ محمد علي : مجمع البحرين ، ج ٤ / ٢١٠.
(٢١٦) ـ ابن الأثير ، المبارك بن محمد الجزري : النهاية في غريب الحديث ، ج ١ / ١٨٧.
(٢١٧) ـ السمهودي ، نور الدين علي بن أحمد : وفاء الوفاء ، ج ٢ / ٤٢٩ ـ ٤٣٢.
(٢١٨) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٧١ / ١٧٧.
(٢١٩) ـ الصدوق ، الشيخ محمد بن علي بن بابويه : معاني الاخبار / ٣٢١.
(٢٢٠) ـ ابن فهد ، الشيخ أحمد بن محمد الحلي : عدة الداعي / ٢٥٣.
الثاني ـ الشيخ يوسف البحراني (قده) : «ويحتمل أن يكون ذلك على الحقيقة في المنبر والروضة ، بأن يكون حقيقتها كذلك ، وإن لم يظهر في الصورة بذلك في الدنيا ؛ لأنّ الحقائق تظهر بالصور المختلفة ، وعن أبي الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ما بين بيتي وقبري ومنبري ، روضة من رياض الجنة ، ومنبري على ترعة من ترع الجنة ، وقوائم منبري ربت في الجنة ، قال : قلت هي روضة اليوم ، قال : نعم لو كشف الغطاء لرأيتم). أقول : وفي هذا الخبر ما يدل على ما ذكره ذلك البعض المتقدم»(٢٢١) . وقريب منه ما ذهب إليه جمع من علماء العامة وأشار إلى ذلك السمهودي بقوله : «وهو أن تلك البقعة نفسها روضة من رياض الجنة كما كان ، ويكون للعامل بالعمل فيه روضة في الجنة ؛ قال : وهو الأظهر ؛ لعلو مكانته عليه السلام ؛ وليكن بينه وبين الأبوة الإبراهيمية في هذا أشبه ، وهو أنّه لما خص الخليل بالحجر من الجنة خص الحبيب بالروضة منها. قلت : وهو من النفاسة بمكان ، وفيه حمل اللفظ على ظاهره ؛ إذ لا مقتضى لصرفه عنه ، ولا يقدح في ذلك كونها تُشَاهَد على نسبة رياض الدنيا ، فإنّ ما دام الإنسان في هذا العالم لا ينكشف له حقائق ذلك العالم ، لوجود الحجب الكثيفة والله أعلم. وتخصيص ما أحاطت به البَيْنيّة المذكورة بذلك ، إما تعبداً وإما لكثرة تردده (صلى الله عليه (وآله) وسلم) بين بيته ومنبره ، وقرب ذلك من قبره الشريف ، الذي هو الروضة العظمى ، كما أشار إليه ابن أبي جَمْرَة أيضاً»(٢٢٢) .
__________________
(٢٢١) ـ البحراني ، الشيخ يوسف بن الشيخ أحمد : الحقائق الناضرة ، ج ١٧ / ٤١٦.
(٢٢٢) ـ السمهودي ، نور الدين علي بن أحمد : وفاء الوفاء ، ج ٢ / ٤٢٩ ـ ٤٣٠.
وقال جمال محمد الراساني الريمي : «إتفقوا على أنّ هذا اللفظ معقول المعنى ، مفهوم الحِكْمَة ، وإنما إختلفوا في ذلك المعنى ما هو؟ فقيل : اللفظ على حقيقته ، وأن ذلك روضة من رياض الجنة ، بمعنى أنه بعينة نقل من الجنة ، أو أنه سينقل إليها»(٢٢٣) .
الثالث ـ الجمع بين الرأيين المتقدمين : لأنّ لكل منهما دليلاً يُعَضِّده ، وإلى هذا ذهب ابن أبي جَمْرَةَ(٢٢٤) وكل هذا الوجوه الثلاثة معتبرة ولها قيمتها في البحث العلمي. وبعد عرض هذه الوجوه ؛ نأتي لتوضيح المراد من الروضة في مسميات كربلاء كالتالي :
أولاً ـ إن موضع قبر الحسين عليه السلام وما حوله ـ الحائر ـ روضة من رياض الجنة ، باعتباره محل نزول الرحمة وحصول السعادة ، وقبول العمل ، وإستجابة الدعاء ، وأنه محل تواجد الملائكة الزائرين له ، والمستغفرين لزواره. فكل هذه الأمور تؤدي إلى الجنة ، فتسميتها بـ(روضة من رياض الجنة) على نحو المجاز ويؤيده ما ورد الروايات التالية :
١ ـ عن إسحاق بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : (إنّ لموضع قبر الحسين عليه السلام ، حرمة معروفة من عرفها واستجار بها أجير. قلت : فصف لي موضعها ، قال : إمسح من موضع قبره اليوم خمسة وعشرين ذراعاً من ناحية رجليه ، وخمسة وعشرين ذراعاً من ناحية رأسه ، وموضع قبره من يوم دفن روضة من رياض الجنة ، ومنه معراج تعرج فيه بأعمال زوّاره إلى
__________________
(٢٢٣) ـ المصدر السابق / ٤٢٩ ـ ٤٣١.
(٢٢٤) ـ نفس المصدر / ٤٣٠.
السماء ، وما من ملك في السماء ولا في الأرض ، إلا وهم يسألون الله أن يأذن لهم في زيارة قبر الحسين عليه السلام ، ففوج ينزل وفوج يعرج)(٢٢٥) .
٢ ـ عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام سمعه يقول : (من زار الحسين يريد به وجه الله ؛ أخرجه الله من ذنوبه كمولود ولدته أمه ، وشيعه الملائكة في مسيره إلى أن يقول : وسألت الملائكة المغفرة له من ربه ، ونادته طبت وطاب من زرت ، وحفظ في أهله)(٢٢٦) .
٣ ـ ما ورد عن إمامنا الهادي عليه السلام : (إن لله مواضع يحب أن يعبد فيها ، وحير الحسين (عليه السلام) من تلك المواضع)(٢٢٧) وأيضاً عنه عليه السلام : (.. وأن لله تبارك وتعالى بقاعاً يحب أن يدعى فيها ، فيستجيب لمن دعاه ، والحائر منها)(٢٢٨) إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة الواردة في فضل كربلاء وفضل زيارتها.
ثانياً ـ أن تكون نفسها روضة من رياض الجنة على نحو الحقيقة ، بحيث لو كشف الغطاء لنا ؛ لوجدناها بقعة من بقاع الجنة ، ويؤيد هذا الوجه ما يلي :
١ ـ عن زينب بنت علي عليهما السلام ، عن أم أيمن قالت في حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : (أتى جبرئيل فأومى إلى الحسين عليه السلام وقال : إنّ سبطك هذا مقتول في عصابة من ذريتك ، وأهل بيتك ، وأخيار من أُمّتك بضفة الفرات بأرض تدعى كربلاء ، من أجلها يكثر الكرب والبلاء على أعدائك وأعداء ذريتك ،
__________________
(٢٢٥) ـ الحر العاملي ، الشيخ محمد بن الحسن : وسائل الشيعة ، ج ١٠ / ٤٠٠ (باب ٦٧ من أبواب المزار ، حديث ٤).
(٢٢٦) ـ نفس المصدر / ٣٨٩ ـ ٣٩٠ (باب ٦٤ من أبواب المزار ، حديث ٩).
(٢٢٧) ـ النوري ، ميرزا حسين الطبرسي : مستدرك الوسائل ، ج ١٠ / ٣٤٦ (باب م ٥٩ من أبواب المزار ، حديث ٢).
(٢٢٨) ـ نفس المصدر / ٣٤٧ ـ ٣٤٨ (الحديث ٣).
في اليوم الذي لا ينقضي كربه ، ولا تفنى حسرته ، وهي أطهر بقاع الأرض ، وأعظمها حرمة ، وإنها من بطحاء الجنة)(٢٢٩) .
٢ ـ وعن عمر بن ثابت ، عن أبيه ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : (خلق الله أرض كربلاء قبل أن يخلق أرض الكعبة بأربعة وعشرين ألف عام ، وقدّسها وبارك عليها ، فما زالت قبل خلق الله الخلق مقدّسة مباركة ، لا تزال كذلك ، حتى يجعلها الله أفضل أرض في الجنة ، وأفضل منزل يسكن الله فيه أولياءه في الجنة)(٢٣٠) .
ثالثاً ـ الجمع بين الروايات بأنها في الدنيا شبيهة برياض الجنة ، من حيث قداستها ، وما يكون فيها من صالح الأعمال ، ويؤيد هذا الوجه الروايات التالية :
١ ـ عن أبي الجارود قال : قال علي بن الحسين عليه السلام : (إتخذ الله أرض كربلاء حرماً آمناً مباركاً قبل أن يخلق أرض الكعبة ، بأربعة وعشرين ألف عام ، وأنها إذا بدّل الله الأرضيين رفعها بما هي برمتها نورانية صافية ، فجعلت في أفضل روضة من رياض الجنة ، وأفضل مسكن في الجنة ، لا يسكنها إلا النبيون والمرسلون ـ أو قال : أولوا العزم من الرسل ـ وأنها لتزهر من رياض الجنة ، كما يزهر الكوكب الدري لأهل الأرض ، يغشى نورها نور أبصار أهل الجنة جميعاً ، وهي تنادي : أنا أرض الله المقدسة والطينة المباركة ، التي تضمنت سيد الشهداء ، وشباب أهل الجنة)(٢٣١) .
__________________
(٢٢٩) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٩٨ / ١١٤ ـ ١١٥.
(٢٣٠) ـ النوري ، ميرزا حسين الطبرسي : مستدرك الوسائل ، ج ١٠ / ٣٢٢ (باب ٥١ من أبواب المزار ، حديث ٢).
(٢٣١) ـ نفس المصدر / ٣٢٢ ـ ٣٢٣ (حديث ٣).
١٩ ـ طين الحائر أو الحير
٢٠ ـ طين الحسين عليه السلام
٢١ ـ طين قبر الحسين عليه السلام
٢٢ ـ ظهر الكوفة
٢٣ ـ قبر الحسين عليه السلام
٢٤ ـ قُبّة الإسلام
٢٥ ـ كربلاء
٢٦ ـ كَرْبٌ وبَلاء
٢٧ ـ مِسْكَة مباركة
٢٨ ـ مشهد الحسين عليه السلام
٢٩ ـ مُقَدّسَة مباركة
٣٠ ـ مكاناً قَصِيّا
١٩ ـ طين الحائر أو الحير :
ذكر هذا الإسم في الروايات التالية :
١ ـ عن محمد بن زياد ، عن عمته قالت : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : (إنّ في طين الحير الذي فيه الحسين عليه السلام ، شفاء من كُلّ داء ، وأماناً من كل خوف)(٢٣٢) .
٢ ـ عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (كنت بمكّى ـ وذكر في حديثه ـ قلت : جعلت فداك ، إني رأيت أصحابنا يأخذون من طين الحائر ليستشفون به ، هل في ذلك شيء مما يقولون من الشفاء؟ قال : يستشفى بما بينه وبين القبر ، على رأس أربعة أميال ، وكذلك قبر جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وكذلك طين قبر الحسين ، وعلي ، ومحمد ، فخذ منها ، فإنّها شفاء من كل سقم ...)(٢٣٣) .
٢٠ ـ طين الحسين (عليه السلام) :
نَصّ على هذا الإسم الحديث التالي :
روى جعفر بن عيسى ، أنّه سمع أبا الحسن عليه السلام يقول : (ما على أحدكم إذا دفن الميت ووسّدَه التراب ، أن يضع مقابل وجهه لبنة من طين الحسين عليه السلام ، ولا يضها تحت رأسه)(٢٣٤) .
٢١ ـ طين قبر الحسين (عليه السلام) :
ورد هذا الإسم في كثير من الروايات نذكر منها ما يلي :
__________________
(٢٣٢) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٩٨ / ١٢٥.
(٢٣٣) ـ بن قولويه ، الشيخ جعفر بن محمد : كامل الزيارات / ٤٧٠ (باب ٩٣ ـ حديث ٥).
(٢٣٤) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٩٨ / ١٣٦.
١ ـ عن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : (يأخذ الإنسان من طين قبر الحسين عليه السلام فينتفع به ، ويأخذ غيره فلا ينتفع به ، فقال : والله الذي لا إله إلا هو ، ما يأخذه أحد ، وهو يرى أنّ الله ينفعه به إلا نفعه به )(٢٣٥) .
٢ ـ عن جابر الجعفي قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : (طين قبر الحسين عليه السلام شفاء من كل داء ، وأمان من كل خوف ، وهو لما أخذ له )(٢٣٦) .
٣ ـ عن محمد بن سليمان البصري ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (في طين قبر الحسين عليه السلام ، الشفاء من كل داء ، وهو الدواء الأكبر )(٢٣٧) .
٢٢ ـ ظهر الكوفة :
عرف هذا الإسم في الروايات وكتب اللغة والتاريخ ، أنّه إسم للبقعة التي دفن فيها أمير المؤمنين عليه السلام (النجف الأشرف) ، إلا أنّ هناك بعض الروايات تنصّ على أنه إسم للبقعة التي دفن فيها سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام (كربلاء) أيضاً ، فمن هنا نحتاج إلى توضيح ما هو المراد بـ(ظهر الكوفة)؟ حتى يتضح لنا سبب إطلاقه على كلا البقعتين كالتالي :
١ ـ قال الشيخ الطريحي (ره) : «وظهر الكوفة ، ما وراء النهر إلى النجف»(٢٣٨) .
٢ ـ ذكر الدكتور مصطفى جواد في بحثه (النجف قديماً) : «وظهر الكوفة : يقال له اللسان ؛ وهو فيما بين النهرين إلى العين : عين بني الجرّاء»(٢٣٩) .
__________________
(٢٣٥) ـ النوري ، ميرزا حسين الطبرسي : مستدرك الوسائل ، ج ١٠ / ٣٢٩ ـ ٣٣٠ (باب ٥٣ من أبواب المزار ـ حديث ١).
(٢٣٦) ـ نفس المصدر / ٣٣٤ ـ ٣٣٥. (باب ٥٣ من أبواب المزار ـ حديث ١٤).
(٢٣٧) ـ نفس المصدر / ٣٣٠. (باب ٥٣ من أبواب المزار ـ حديث ٣).
(٢٣٨) ـ الطريحي ، الشيخ فخر الدين : مجمع البحرين ، ج ٣ / ٣٩٠.
(٢٣٩) ـ الخليلي ، جعفر : موسوعة العتبات المقدسة ، ج ٩ / ١٢.
٣ ـ يذكر الحاج عبد المحسن شلاش : «ولنا من الأدلة الشرعية ما يؤيد حدود كوفان نظراً لما ورد في الجزء العاشر من البحار : عن الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال لولده الحسين عليه السلام : (بأبي المقتول على ظهر كوفان) والمفروض أنّه المقتول في أكتاف طف كربلاء ، وهذا ما يحملنا أيضاً الإعتقاد بأنّ ظهر الكوفة ربما كان يمتد إلى غربي طف كربلاء ؛ حيث أنّ هذا السنام المرتفع من الرمال المتحجرة كان يرافق أراضي الطفوف الواقعة غربي طف كربلاء؟ كطف هور أبو دبس وما يجاورها»(٢٤٠) . وبعد عرض هذه الأقوال نخرج بالنتيجة التالية :
أولاً ـ لعلّ الإختلاف في توضيح (ظهر الكوفة) كما تقدم يرجع إلى أنّ تحديد الكوفة هل هو قبل الإسلام أم بعد الإسلام؟ حيث أن المنقبين في الأخبار والآثار توصلوا إلى أنّ حدودها القديمة قبل الإسلام أوسع من حدودها بعد الإسلام.
ثانياً ـ على القول بأن سبب تسمية الكوفة هو إستدارتها ، أو للرميلة المستديرة ، أو لوقوع جبل كان في وسطها ، فإن نتيجة البحث والتتبع لدى الباحثين في هذا الموضوع ، أنّ البقعة الرملية الواقعة على جانب الفرات الغربي كأنها جبل مكتوف من الرمال المرتفعة ، بخلاف الأراضي المحيطة به حيث ترتفع إرتفاعاً بيناً بالتدريج يبلغ إلى ستة وثلاثين متراً تقريباً مما يلي النجف عن شاطئ الفرات ، وهو الذي تحده من الجنوب بحرية النجف المنخفضة ، ومن الشرق منخفضات أراضي المشخاب والشامية التي تقطنها اليوم قبائل آل فتلة وآل إبراهيم وآل زياد ، ومن الشمال مقاطعات زراعية منخفضة
__________________
(٢٤٠) ـ الدجيلي ، جعفر هادي : موسوعة النجف الأشرف ، ج ١ / ١٤٥.
تقطنها قبائل بن حسن (أراضي الهندية) ، ومن الغرب منخفضات طف كربلاء ، إذن إسم كوفان كان يشمل هذه البقعة المرتفعة الرملية المستديرة بحدودها المارة(٢٤١) .
ثالثاً ـ إتضح لنا أن كربلاء داخل في ظهر الكوفة على حسب ما تقدم ، بل يمكن للباحث أن يالحظ ما يلي :
١ ـ الطف : «أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية ، فيها كان مقتل الحسين بن علي»(٢٤٢) .
٢ ـ نينوى : «وبسواد الكوفة ناحية يقال لها نينوى ، منها كربلاء التي قتل فيها الحسين (رضي الله عنه)»(٢٤٣) .
٣ ـ الغاضرية : «قرية من نواحي الكوفة قريبة من كربلاء»(٢٤٤) .
٤ ـ عقر بابل : «قرب كربلاء من نواحي الكوفة»(٢٤٥) .
فالمتأمل في هذه الحدود من خلال قرى كربلاء ، يتضح له أنّ لها حدوداً مع الكوفة من ناحية منطقة ظهر الكوفة.
وبعد هذا البيان ، نذكر بعض الروايات الناصّة على قتله بظهر الكوفة كالتالي :
__________________
(٢٤١) ـ المصدر السابق (بتصرف).
(٢٤٢) ـ الحموي ، شهاب الدين ياقوت بن عبد الله : معجم البلدان ، ج ٤ / ٣٦.
(٢٤٣) ـ نفس المصدر ، ج ٥ / ٣٣٩.
(٢٤٤) ـ البغدادي ، عبد المؤمن بن عبد الحق : مراصد الإطلاع ، ج ٢ / ٩٨٠.
(٢٤٥) ـ نفس المصدر / ٩٥٠.
عن الحارث الأعور ، قال : (قال علي عليه السلام : بأبي وأمي الحسين المقتول بظهر الكوفة ، والله لكأني أنظر إلى الوحش مادة أعناقها على قبره ، من أنواع الوحش يبكونه ويرثونه ليلاً حتى الصباح ، فإذا كان ذلك فإياكم والجفاء)(٢٤٦) .
ولكن قد يسأل البعض ويقول : إنّ بعض الروايات تذكر أن المدفون بظهر الكوفة هو رأس الحسين عليه السلام ، فلعل المراد من الرواية السابقة هو ذلك؟
هناك ثلاث روايات تحتاج إلى إيضاح ، وهي كالتالي :
الأولى ـ عن يزيد بن عمر بن طلحة ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ـ وهو بالحيرة ـ : (أما تريد ما وعدتك ، قال : قلت : بلى ـ يعني الذهاب إلى قبر أمير المؤمنين عليه السلام ـ ، قال : فركب وركب إسماعيل ابنه معه ، وركبت معهم ، حتى إذا جاز الثوية ، وكان بين الحيرة والنجف عند ذكوات بيض ، ونزل إسماعيل ونزلت معهم ، فصلّى وصلّى إسماعيل وصليت ، فقال إسماعيل : قم فسلم على جدك الحسين بن علي (عليهما السلام). فقلت : دعلت فداك ، أليس الحسين عليه السلام بكربلاء؟ فقال : نعم ، ولكن لما حمل رأسه إلى الشام ؛ سرقه مولى لنا فدفنه بجنب أمير المؤمنين عليه السلام)(٢٤٧) .
الثانية ـ عن أبان بن تغلب ، قال : (كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فمرّ بظهر الكوفة فنزل وصلّى ركعتين ، ثم تقدم قليلاً ، فصلّى ركعتين ، ثم سار قليلاً ، فصلى ركعتين ، ثم قال : هذا موضع قبر أمير المؤمنين عليه السلام ،
__________________
(٢٤٦) ـ بن قولويه ، الشيخ جعفر بن محمد : كامل الزيارات / ١٦٥ (باب ٢٦ ـ حديث ٣).
(٢٤٧) ـ نفس المصدر / ٨٣ (الباب ٩ ـ حديث ٤).
قلت : جعلت فداك ، فما الموضعين الذين صليت فيهما؟ قال : موضع رأس الحسين عليه السلام ، وموضع منبر القائم)(٢٤٨) .
الثالثة ـ عن علي بن أسباط ، رفعه ، قال أبو عبد الله عليه السلام : (إنك إذا أتيت الغريّ رأيت قبرين ، قبراً كبيراً وقبراً صغيراً ، فأما الكبير ؛ فقبر أمير المؤمنين ، وأما الصغير ، فرأس الحسين بن علي (عليهما السلام))(٢٤٩) .
وبعد عرض هذه الروايات ، نستنتج ما يلي :
١ ـ بناء على الرواية الأولى ذهب بعض العلماء إلى القول بدفن الرأس بجنب أمير المؤمنين عليه السلام وعلى هذا يشير الشيخ عباس القمي (ره) بقوله : «والذي اشتهر بين علمائنا الإمامية ، أنه إما دفن مع جسده الشريف ، رده علي بن الحسين (عليه السلام) ، وأنه دفن عند أمير المؤمنين (عليه السلام) ، كما في أخبار كثيرة»(٢٥٠) .
٢ ـ قال الشيخ محمد بن حسن النجفي (قده) : «وقال يونس بن ظبيان : (إنّ الصادق عليه السلام ركب وركبت معه حتى نزل عند الذكوات الحمر ، وتوضأ ثم دنى إلى أكمة فصلى عندها وبكى ، ثم مال إلى أكمة دونها ففعل مثل ذلك. ثم قال : الموضع الذي صَلّيت عنده أولاً ، موضع قبر أمير المؤمنين عليه السلام ، والآخر موضع رأس الحسين عليه السلام ، وأنّ ابن زياد (لعنه الله) لما بعث برأس الحسين بن علي عليهما السلام) إلى الشام ؛ بعثه إلى الكوفة ، فقال :
__________________
(٢٤٨) ـ المصدر السابق / ٨٣ (حديث ٥).
(٢٤٩) ـ نفس المصدر / ٨٤ (حديث ٦).
(٢٥٠) ـ القمي ، الشيخ عباس : نفس المهموم / ٤٢٥.
أخرجوه منها لا يفتتن به أهلها ، فصيّره الله تعالى عند أمير المؤمنين عليه السلام فدفن ، فالرأس مع الجسد ، والجسد مع الرأس»(٢٥١) .
لكن عن ابن طاووس : «أنّ رأس الحسين عليه السلام أعيد فدفن مع بدنه بكربلاء ، وذكر أنّ عمل العصابة على ذلك؟ ولعلّه لا منافاة لإمكان دفنه مدة ، ثم نقل إلى كربلاء. ولا بأس بالصلاة وزيارته بمكان وضعه.
قال مفضل بن عمر : (جاز الصادق عليه السلام بالقائم المائل في طريق الغري ، فصلى عنده ركعتين ، فقيل له : ما هذه الصلاة؟ فقال : هذا موضع رأس جدي الحسين عليه السلام وضعوه هنا)(٢٥٢) .
ويمكن أن يكون المكان موضع دفن الرأس الشريف بعد سلخه ، فإنهم لعنهم الله تعالى نقلوه بعد أن سلخوه»(٢٥٣) .
ما المراد بـ(فالرأس مع الجسد ، والجسد مع الرأس)؟
يمكن توجيه هذه العبارة بما يلي :
أ ـ قال الشيخ المجلسي (ره) : «أي بعد ما دفن هناك ظاهراً ألحق بالجسد بكربلاء ، أو صعد به مع الجسد إلى السماء ، كما في بعض الأخبار ، أو أنّ بدن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كالجسد لذلك الرأس ، وهما من نور واحد»(٢٥٤) .
ب ـ وقال السيد ابن طاووس (ره) : «اعلم أنّ إعادة مقدّس رأس مولانا الحسين عليه السلام إلى جسده الشريف يشهد به لسان القرآن العظيم المنيف ، حيث
__________________
(٢٥١) ـ الحر العاملي ، الشيخ محمد بن الحسن : وسائل الشيعة ، ج ١٤ / ٤٠٢ (الباب ٣٣ ـ من أبواب المزار ـ حديث ٨).
(٢٥٢) ـ نفس المصدر / ٤٠١ (الحديث ٦).
(٢٥٣) ـ النجفي ، الشيخ محمد بن حسن : جواهر الكلام ، ج ٢٠ / ٩٣.
(٢٥٤) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٤٥ / ١٧٨.
قال الله جَلّ جلاله : ( وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ) (٢٥٥) . فهل بقي شك؟ حيث أخبر الله أنّه من حيث استشهد حيّ عند ربّه مرزوق مصون ، فلا ينبغي أن يشك في هذا العارفون ، وأما كيفيّة إحيائه بعد شهادته وكيفيّة جمع رأسه الشريف إلى جسده بعد مفارقته ، فهذا سؤال يكون فيه سوء أدب من العبد على الله جل جلاله أن يُعرّفه كيفيّة تدبير مقدوراته ، وهو جهل من العبد وإقدام على ما لم يكلّف العلم به ، ولا السؤال عن صفاته»(٢٥٦) .
٣ ـ المشهور بين علماء الإمامية أنّه أعيد إلى كربلاء ودفن مع الجسد الطاهر. وكذلك أشتهر عند علماء العامة ، قال السبط بن الجوزي : «أشهرها أنه رده إلى ال مدينة مع السبايا ، ثم رد إلى الجسد بكربلاء فدفن معه»(٢٥٧) . وقد ذكر هذه الأقوال السيد عبد الرزاق المقرّم ، وعَقّب عليها بقوله : «وعلى هذا ، فلا يعبأ بكل ما ورد بخلافه ، والحديث بأنّه عند قبر أبيه بمرأى من هؤلاء الأعلام ، فإعراضهم عنه يدلنا على عدم وثوقهم به ؛ لأنّ إسناده لم يتم ورجاله غير معروفين»(٢٥٨) .
أقول : بعد إيضاح ما تقدم ؛ تبيّن لنا أنّ كربلاء يطلق عليها ظهر الكوفة ، كما يطلق على النجف الأشرف ، إلا أنّ إطلاق هذا الإسم على قبر أمير المؤمنين أكثر.
__________________
(٢٥٥) ـ آل عمران / ١٦٩.
(٢٥٦) ـ ابن طاووس ، السيد رضي الدين : إقبال الأعمال / ٦٥.
(٢٥٧) ـ سبط ابن الجوزي ، يوسف بن فرغلي : تذكرة الخواص / ١٥٠.
(٢٥٨) ـ المقرّم ، السيد عبد الرزاق : مقتل الحسين / ٣٦٣.
٢٣ ـ قبر الحسين (عليه السلام) :
ورد هذا الإسم في كثير من الروايات نذكر منها التالي :
١ ـ عن داود بن فرقد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : (ما لمن زار قبر الحسين عليه السلام في كل شهر من الثواب؟ قال : له الثواب ، مثل ثواب مائة ألف شهيد من شهداء بدر)(٢٥٩) .
٢ ـ عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (الزيارة إلى قبر الحسين عليه السلام حجة ، وبعد الحجة ، حجة وعمرة ، بعد حجة الإسلام)(٢٦٠) .
٣ ـ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (حريم قبر الحسين عليه السلام ، خمس فراسخ من أربعة جوانب القبر)(٢٦١) .
٤ ـ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (حرمة قبر الحسين عليه السلام ، فرسخ من أربعة جوانب القبر)(٢٦٢) .
٥ ـ عن رجل من أهل الكوفة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : (مريم قبر الحسين عليه السلام فرسخ في فرسخ في فرسخ في فرسخ)(٢٦٣) .
٦ ـ عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (سمعته يقول : قبر الحسين عليه السلام ، عشرون ذراعاً مُكَسّراً ، روضة من رياض الجنة)(٢٦٤) .
__________________
(٢٥٩) ـ النوري ، ميرزا حسين الطبرسي : مستدرك الوسائل ، ج ١٠ / ٣٤٤. (باب ٥٣ من أبواب المزار ـ حديث ٢).
(٢٦٠) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٩٨ / ٣٩.
(٢٦١) ـ النوري ، ميرزا حسين الطبرسي : مستدرك الوسائل ، ج ١٠ / ٣٢٠. (باب ٥٠ من أبواب المزار ـ حديث ٣)ز
(٢٦٢) ـ نفس المصدر / ٣٢٠. (باب ٥٠ ـ من أبواب المزار ـ حديث ٢).
(٢٦٣) ـ نفس المصدر / ٣٢٠ ـ ٣٢١. (باب ٥٠ ـ من أبواب المزار ـ حديث ٥).
(٢٦٤) ـ نفس المصدر / ٣٢٠. (باب ٥٠ ـ من أبواب المزار ـ حديث ٤).
٧ ـ وروى الملا : (إنّ علياً مَرّ بقبر الحسين ـ يعني بموضع قبره ـ فقال : هاهنا مناخ ركابهم ، وهاهنا موضع رحالهم ، وهاهنا مهراق دمائهم ، فتية من آل محمد صلى الله عليه وآله ووسلم ، يقتلون بهذه العرصة ، تبكي عليهم السماء والأرض)(٢٦٥) .
٢٤ ـ قُبّة الإسلام :
ورد هذا الإسم في الرواية التالية :
عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يقبر إبني بأرض يقال لها : كربلاء ؛ هي البقعة التي كانت فيها قبة الإسلام ، التي نجّا الله عليها المؤمنين الذين آمنوا مع نوح في الطوفان)(٢٦٦) .
أقول : المعروف أنّ قبة الإسلام ؛ هي الكوفة كما في الرواية التالية :
«فروي عن العالم عليه السلام أنه قال : (فمن هناك تناسل الخلق ، وعقد نوح في وسط المسجد قبة ، فأدخل إليها أهله وولده والمؤمنين ، إلى أنّ مَصّر الأمصار ، وأسكن ولده البلدان ، فسميت الكوفة قبة الإسلام بسبب تلك القبة)»(٢٦٧) . وهذا خلاف ما جاء في الرواية المتقدمة.
ويمكن أن يجاب عن ذلك : بأنّ قبة الإسلام ربما كانت في كربلاء ؛ وذلك حينما ناجي نوح ربه كما في الرواية التالية :
قال أبو جعفر عليه السلام : (الغاضريّة : هي البقعة التي كَلّم الله فيها موسى بن عمران ، وناجى نوحاً فيها ، وهي أكرم أرض الله عليه ، ولولا ذلك ما استودع الله فيها أولياءه وأبناء نبيه ، فزوروا قبورنا بالغاضرية)(٢٦٨) .
__________________
(٢٦٥) ـ ابن حجر ، أمد بن علي الهيثمي : الصواعق الامحرقة / ١١٥.
(٢٦٦) ـ بن قولويه ، الشيخ جعفر بن محمد : كامل الزيارات / ٤٥٢.
(٢٦٧) ـ المسعودي ، علي بن حسين : إثبات الوصية / ٣١ ـ ٣٢.
(٢٦٨) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٩٨ / ١٠٨ ـ ١٠٩.
٢٥ ـ كربلاء :
قال العلامة الشيخ عبد الواحد المظفر (ره) : «كربلاء الإسم الحائز الشهرة العظيمة التي طوت الأجيال ، ولفت العصور لقداستها بما حوته من جثمان سيد شباب أهل الجنة ، وضمنته من جسد خير فتيان المسلمين قاطبة ، سيد الشهداء وسبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته الحسين ابن علي عليه السلام ، وهي في الأصل اسم لموضع خاص من مواضع هذه الأرض الواسعة الفسيحة ، غلب على الصقع بأسره ، وهو من دونها موضع قاحل ، أرضه جرداء لا نبات بها ، سوى الحلفاء وبعض الأدغال ، وليس فيها ماء في ذلك الوقت ولا سكان ، وبهذا الموضع نزل الحسين عليه السلام»(٢٦٩) .
وقال الدكتور سلمان آل طعمة : «تقع كربلاء غرب نهر الفرات على حافة البادية ، وسط المنطقة الرسوبية المعروفة بأرض السواد ، وعلى شمالها الغربي مدينة الأنبار ، وعلى شرقها مدينة باب الأثرية ، وفي الغرب منها مدينة الحيرة عاصمة المناذرة»(٢٧٠) .
ويرى أصحاب اللغة أن رد (كربلاء) إلى أصول عربية كالتالي :
قال ياقوت الحموي : «كَرْبَلاء : بالمد : وهو الموضع الذي قتل فيه الحسين ابن علي ـ رضي الله عنه ـ في طرف البرية عند الكوفة ، فأما اشتقاقه فالكربلة رخاوة في القدمين ، يقال : جاء يمشي مُكَرْبلاً ، فيجوز على ، هذا أن تكون أرض هذا الموضع رَخْوة فسميت بذلك ، ويقال " كَرْبلْتُ الحنطة إذ هَذّبْتَها ونقيتها ، وينشد في صفة الحنطة :
__________________
(٢٦٩) ـ المظفر ، الشيخ عبد الواحد : البطل العلقمي ، ج ٣ / ٣٢٤.
(٢٧٠) ـ آل طعمة ، السيد سلمان هادي : تاريخ مرقد الحسين والعباس / ١٧.
يحملن حمراء رسوباً للثقلْ |
قد غُربلت وكُرْبلَت من القَصَلْ |
فيجوز على هذا ، أنّ هذه الأرض مُنْقاة من الحصى والدَّغَل فسميت بذلك ، والكَرْبَل : اسم نبت الحُمّاض ؛ فيجوز أن يكون هذا الصنف من النبت يكثر نبته هناك فسمي به»(٢٧١) .
وقال ابن منظور : «والكَرْبَل : نبت له نور أحمر مشرق ، حكاه أبو حنيفة وأنشد :
كأنّ جنى الدِّفلى يُغشّى خُدرها |
ونُوّارُ ضاحٍ من خُزامى وكرْبَل»(٢٧٢) . |
ويرى الدكتور مصطفى جواد : «وأنا أرى محاولة ياقوت الحموي رَدَّ «كربلاء» إلى الأصول العربية غير مجدية ، ولا يصح الإعتماد عليها ، لأنّها من باب الظن والتخمين ، والرغبة الجامحة العارمة في إدارة جعل العربية مصدراً لسائر الأمكنة والبقاع ، مع أنّ موقع كربلاء خارج عن جزيرة العرب ، وأنّ في العراق كثيراً من البلدان ليست أسماؤها عربية ، كبغداد وصرورا وجوخا وبابل وكوش وبعقوبا ، وأنّ التاريخ لم ينص على عروبة اسم «كربلاء» ولقائل أن يقول : إنّ العرب أوطنوا تلك البقاع قبل الفتح العربي ، فدولة المناذرة بالحيرة ونواحيها ، كانت معاصرة للدولة الساسانية الفارسية ، وفي حمياتها وخدمتها؟ والجواب : إنّ المؤرخين لم يذكروا لهم إنشاء قرية سميت بهذا الإسم ـ أعني كربلاء ـ غير أنّ وزن كربلاء ألحق بالأوزان العربية ، ونقل «فَعْلَلا» إلى «فَعْللاء» في الشعر حَسْبُ. فالأول موازن لجحجحى ، وقرقرى ، وقهقهرى ، والثاني موازن لعقرباء وحرملاء ، زيد همزة كما زيد بَرْنساء.
__________________
(٢٧١) ـ الحموي ، شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت : معجم البلدان ، ج ٤ / ٤٤٥.
(٢٧٢) ـ ابن منظور ، محمد بن مكرم : لسان العرب ، ج ١١ : ٥٨٦ ـ ٥٨٧.
وعلى حسبان «كربلاء» من الأسماء السامية الآراميّة أو البابلية ، تكون القرية من القرى القديمة الزمان كبابل وكيف لا ، وهي من ناحية «نينوى» الجنوبية(٢٧٣) .
ومهما ذكر المؤرخون وأهل اللغة عن لفظة (كربلاء) ، فإنها الأرض المباركة التي ذكرتها الروايات ، ونذكر منها ما يلي :
أ ـ مرويات السنة :
١ ـعن أم سلمة قالت : (كان جبريل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحسين عليه السلام معه فبكى فتركته ، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال له جبريل : أتحبه يا محمد؟ قال : نعم. قال : إنّ أمتك ستقتله ، وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل بها ، فبسط جناحه إلى الأرض ، فأراه أرضاً يقال لها كربلا)(٢٧٤) .
٢ ـروي من طريق الطبراني : عن أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (إنّ جبريل كان معنا في البيت فقال : أتحبه يعني الحسين؟ فقلت : أما في الدنيا فنعم ، فقال : إنّ أمتك ستقتل هذا بأرض يقال لها كربلاء ، فتناول جبريل من تربته فأرانيه)(٢٧٥) .
٣ ـعن أنس بن الحارث أنه قال : (سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : (إنّ ابني هذا ـ يعني الحسين ـ يقتل بأرض كربلاء ، فمن شهد منكم ذلك فلينصره. قال سحيم فخرج أنس إلى كربلاء فقتل)(٢٧٦) .
__________________
(٢٧٣) ـ الخليلي ، جعفر بن الشيخ أسد الله : موسوعة العتبات المقدسة ، ج ١٣ / ١٠ ـ ١٥.
(٢٧٤) ـ الطبري ، محب الدين أحمد : ذخائر العقبى / ١٤٧.
(٢٧٥) ـ المرعشي ، السيد شهاب الدين : ملحقات احقاق الحق ، ج ١١ / ٣٤٢. (عن كنز العمال ج ٣ / ١١١ ـ حيدر آباد الدكن).
(٢٧٦) ـ نفس المصدر / ٣٨١ (عن تاريخ دمشق ، ج ٤ / ٣٣٨ ـ روضة الشام).
٤ ـوأخرج البيهقي ، وأبو نعيم ، عن أنس قال : (إستأذن ملك المطر أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأذن له ، فدخل الحسين فجعل يقع على منكب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال الملك : أتحبه؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : نعم. قال : فإنّ أمّتك تقتله وإذا شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه ، فأراه تراباً أحمر ، فأخذته أمّ سلمة فصرّته في ثوبها ، فكنا نسمع أنّه يقتل بكربلاء)(٢٧٧) .
ب ـ مرويات الإمامية :
١ ـعن عبد الله بن يحيى قال : (دخلا مع علي إلى صفين ، فلما حاذى نينوى ، نادى صبراً يا أبا عبد الله ، فقال : دخلت على رسول الله وعيناه تفيضان فقلت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما لعينيك تفيضان؟ أغضبك أحد؟ قال : لا ، بل كان عندي جبرئيل فأخبرني أنّ الحسين يقتل بشاطئ الفرات ، وقال : هل لك أن أشمّك من تربته؟ قلت : نعم ، فمدّ يده فأخذ قبضة من تراب فأعطانيها ، فلم أملك عيني أن فاضتا ، واسم الأرض كربلاء)(٢٧٨) .
٢ ـعن محمد بن سنان عمن حدّثه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (خرج أمير المؤمنين عليه السلام بالناس حى إذا كان من كربلاء على مسيرة ميل أو ميلين ، فتقدم بين أيديهم حتى إذا صار بمصارع الشهداء قال : قبض فيها مائتا نبي ، ومائتا وصي ، ومائتا سبط شهداء بأتباعهم ، فطاف بها على بغلته خارجاً رجليه من الركاب ، وأنشأ يقول : مناخ ركاب ، ومصارع شهداء لا يسبقهم من كان قبلهم ، ولا يلحقهم من كان بعدهم)(٢٧٩) .
__________________
(٢٧٧) ـ نفس المصدر / ٤٠٦ ـ ٤٠٧ (عن الخصايص للسيوطي ، ج ٢ / ١٢٥ ـ حيدر آباد الدكن).
(٢٧٨) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٤٤ / ٢٤٧ ـ ٢٤٨.
(٢٧٩) ـ نفس المصدر ، ج ٩٨ / ١١٦.
٣ ـعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : (بينما الحسين بن علي عليه السلام عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، إذ أتاه جبرئيل عليه السلام فقال : يا محمد أتحبه؟ فقال : نعم. فقال : أما إن أمتك ستقتله. قال : فحزن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حزناَ شديداً. فقال له جبريل : يا رسول الله أيسرك أن أريك التربة التي يقتل فيها؟ فقال : نعم ، فخسف ما بين مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى كربلاء حتى إلتفت القطعتان هكذا ـ ثم جمع بين السبابتين ـ ، ثم تناول بجناحه من التربة وناولها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم رجعت أسرع من طرفة عين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : طوبى لك من تربة ، وطوبى لمن يقتل فيك)(٢٨٠) .
٤ ـعن ميسرة بن عبد العزيز ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : (كتب الحسين بن علي عليه السلام ، إلى محمد بن علي عليه السلام من كربلاء : بسم الله الرحمن الرحيم ، من الحسين بن علي عليه السلام ، إلى محمد بن علي ومن قبله من بني هاشم ، أما بعد ، فكأنّ الدنيا لم تكن ، وكأنّ الآخرة لم تزل ، والسلام)(٢٨١) .
٥ ـعن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام : (إنّ من أحب أن يكون مسكنة الجنة ، ومأواه الجنة ، فلا يدع زيارة المظلوم ، قلت : من هو؟ قال : الحسين بن علي صاحب كربلاء ، من أتاه شوقاً إليه ، وحباً لرسول الله ، وحباً لأمير المؤمنين ، وحباً لفاطمة عليها السلام ، أقعده الله على موائد الجنة ، يأكل معهم والناس في الحساب)(٢٨٢) .
__________________
(٢٨٠) ـ بن قولويه ، الشيخ جعفر بن محمد : كامل الزيارات / ١٣٠.
(٢٨١) ـ نفس المصدر / ١٥٨.
(٢٨٢) ـ نفس المصدر / ٢٧٠.
٦ ـعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : (إنّ الحسين صاحب كربلاء ، قتل مظلوماً مكروباً عطشاناً لهفاناً ، حق على الله عَزّ وجَلّ أن لا يأتيه لهفان ، ولا ذو عاهة ، ثم دعا عنده وتقرب بالحسين عليه السلام إلى الله عَزّ وجَلّ ، إلا نفّس الله كربته ، وأعطاه مسألته ، وغفر ذنبه ومد في عمره ، وبسط في رزقه ، فاعتبروا يا أولى الأبصار)(٢٨٣) . إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة.
٢٦ ـ كرب وبلاء :
هذا الإسم ذكره الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ومن جاء بعده من أهل بيته الأطهار عليهم السلام ، حسبما نَصّت عليه الروايات التالية :
أ ـ مرويات السنة :
١ ـ وقال ابن عباس : (خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبلم وته بأيام يسيرة إلى سفر له ، ثم رجع وهو متغير اللون محمر الوجة ، فخطب خطبة بليغة موجزة ، وعيناه تهملان دموعاً ، قال فيها : أيها الناس ، إني خَلّفت فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي ؛ فساق الخطبة إلى أن قال : ألا وإنّ جبرئيل قد أخبرني ، بأنّ أمتي تقتل ولدي الحسين بأرض كرب وبلاء ، ألا فلعنة الله على قاتله وخاذله آخر الدهر)(٢٨٤) .
٢ ـ وأخرج الطبراني باسناد رجال ـ أحدهما كما قال الحافظ الهيثمي ثقات ـ عن أم سلمة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالساً ذات يوم في بيتي ، قال : لا يدخل عليّ أحد ، فانتظرت فدخل الحسين ، فسمعت نشيج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخلت ، فإذا حسين في حجره ، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسح جبينه وهو يبكي فقلت : والله ما
__________________
(٢٨٣) ـ المصدر السابق / ٣١٣.
(٢٨٤) ـ المرعشي : السيد شهاب الدين : ملحقات الإلحاق / ج ١١ / ٣٦٤ (عن مقتل الخوارزمي ، ج ١ / ١٦٤ ـ الغري).
عملت حين دخل. فقال : إنّ جبريل كان معنا في البتي ، فقال تحبه؟ فقلت أما في الدنيا فنعم. إن أمتك ستقتله بأرض يقال لها كربلاء ، فتناول جبريل من تربتها فأراها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فلما أحيط بحسين حين قتل قال : ما اسم هذه الأرض؟ قالوا : كربلاء ، قال : صدق الله ورسوله كرب وبلاء)(٢٨٥) .
٣ ـ عن سعيد بن جبهان : (إنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه جبريل بتراب من تراب القرية التي يقتل بها الحسين ، فقال : اسمها كربلاء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : كرب وبلاء)(٢٨٦) .
ب ـ مرويات الإمامية :
١ ـ عن ابن عباس قال : (كنت مع أمير المؤمنين عليه السلام في خرجته إلى صفين ، فلما نزل بنينوى ، هو بشط الفرات ، قال بأعلى صوته : يا ابن عباس أتعرف هذا الموضع؟ قلت له : ما أعرفه يا أمير المؤمنين ، فقال عليه السلام لو عرفته كمعرفتي لم تكن تجوزه حتى تبكي كبكائي «وساق الحديث إلى أن قال» : والذي نفس علي بيده ، لقد حدثني الصادق المصدق ، أبو القاسم صلى الله عليه وآله ، أني سأراها في خروجي إلى أهل البغي علينا ، هذه أرض كرب وبلاء ، يدفن فيها الحسين عليه السلام وسبعة عشر من ولدي وولد فاطمة ، وأنّها لفي السماوات معروفة ، تذكر أرض كرب وبلاء ، كما تذكر بقعة الحرمين ، وبقعة بيت المقدس إلخ)(٢٨٧) .
__________________
(٢٨٥) ـ السمهودي ، نور الدين علي بن أحمد : جواهر العقدين / ٤٠٤.
(٢٨٦) ـ العسكري ، السيد مرتضى : معالم المدرستين ، ج ٣ / ٣٦. (عن تاريخ أبن كثير ٨ / ٢٠٠).
(٢٨٧) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار / ج ٤٤ / ٢٥٢ ـ ٢٥٣.
٢ ـ في كتاب مقتل الحسين عليه السلام لأبي مخنف : (وإنّ الحسين لمّا نزل كربلاء وأخبر بإسمها ، بكى بكاءً شديداً وقال : أرض كرب وبلاء ، قفوا ولا تبرحوا ، وحطّوا ولا ترحلوا ، فها هنا والله محط رحالنا ، وها هنا والله سفك دمائنا ، وها هنا والله تسبى حريمنا ، وها هنا والله محل قبورنا ، وها هنا والله محشرنا ومنشرنا ، وبهذا وعدني جدّي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا خلاف لوعده)(٢٨٨) .
٣ ـ وفي حديث ابن عباس عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال : (وأمّا الحسين فإنّه مني ، وهو ابني وولدي ، وخير الخلق بعد أخيه ، وهو إمام المسلمين ومولى المؤمنين ، وخليفة رب العالمين ، وغياث المستغيثين ، وكهف المستجيرين ، وحجة الله على خلقه أجمعين ، وهو سيّد شباب أهل الجنّة ، وباب نجاة الأمة أمره أمري ، وطاعته طاعتي ، ومن تبعه فإنّه مني ، ومن عصاه فليس مني ، وإني لما رأيته تذكرت ما يصنع به بعدي ، كأنّي به وقد إستجار بحرمي وقبري فلا يُجار ، فأضمّه في منامه إلى صدري ، وأمره بالرحلة عن دار هجرتي ، وأبشره بالشهادة ، فيرتحل عنها إلى أرض مقتله ، وموضع مصرعه أرض كرب وبلاء ، وقتل وفناء ، تنصره عصابة من المسلمين ، أولئك من سادة شهداء أمتي يوم القيامة ، كأنّي أنظر إليه وقد رُمي بسهم فخرّ عن فرسه صريعاً ، ثم يذبح كما يذبح الكبش مظلوماً)(٢٨٩) .
٤ ـ عن إبراهيم بن أبي محمود ، قال الرضا عليه السلام : (إنّ المحرّم كان أهل الجاهلية يُحرّمون فيه القتال ، فاستحلّت فيه دماؤنا ، وهُتِكَت فيه حرمتنا ، وسبي فيه ذرارينا ونساؤنا ، وأضرمت النيران في مضاربنا ، وانتهب ما فيها من ثقلنا ،
__________________
(٢٨٨) ـ الحويزي ، الشيخ عبد علي بن جمعة العروسي : تفسير نور الثقلين ، ج ٥ / ٤٤٢.
(٢٨٩) ـ الصدوق : الشيخ محمد بن علي بن بابويه : أمالي الصدوق / ٤٧٩ ـ (المجلس ٨٧ ـ الحديث ٥).
ولم ترع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حُرمة في أمرنا. إنّ يوم الحسين أقرح جفوننا ، وأسبل دموعنا ، وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء ، وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الإنقضاء ، فعلى مثل الحسين فليبك الباكون ، فإنّ البكاء يحط الذنوب العظام)(٢٩٠) .
٢٧ ـ مِسْكة مباركة :
ورد هذا الاسم في الرواية التالية :
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (إنّ طين قبر الحسين عليه السلام مسكة مباركة ، من أكله من شيعتنا ؛ كان له شفاء من كل داء ، ومن أكله من عدونا ؛ ذاب كما تذوب الألية إلخ)(٢٩١) .
قال الشيخ المجلسي (قده) : «قوله عليه السلام : (مسكة مباركة). قال الفيروز آبادي : المسكة بالضم ما يتمسّك به ، وما يمسك الأبدان من الغذاء والشراب وما يتبلّغ به منهما ، انتهى. أقول : يحتمل أن يقرأ بالكسر أيضا للإشارة إلى طيب ريحها»(٢٩٢) .
ويؤيد هذا الإحتمال ما يلي :
١ ـ عن أبي الجارود قال (حُفِرَ عند قبر الحسين عليه السلام ، ند رأسه ، وعند رجليه أول ما حفر ، فأخرج مسك أذفر لم يشكّوا فيه)(٢٩٣) .
٢ ـ في حديث ابن عباس عن أمير المؤمنين عليه السلام لما نزل بنينوى ، في حديث يذكر فيه مرور عيسى عليه السلام بأرض كربلاء قال : (فجلس عيسى عليه السلام ، وجلس
__________________
(٢٩٠) ـ المصدر السابق / ١١١. (المجلس ٢٧ ـ الحديث ٢).
(٢٩١) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٩٨ / ١٣٢.
(٢٩٢) ـ نفس المصدر.
(٢٩٣) ـ المحمودي ، محمد جواد : ترتيب الأمالي ، ج ٥ / ٢٧١ ، (عن أمالي الطوسي ، المجلس ١١ ـ الحديث ٩٠).
الحواريون معه ، فبكى وبكى الحواريون وهم لا يدرون لِمَ جلس ، ولِمَ بكى؟ فقالوا : يا روح الله وكلمته ما يبكيك؟ قال : أتعلمون أي أرض ههذ؟ قالوا : لا. قال : هذه أرض يقتل فيها فرخ الرسول أحمد ، وفرخ الحُرّة الطاهرة البتول ، شبيهة أمي ويلحد فيها ، طينة أطيب من ال مسك ؛ لأنها طينة الفرخ المستشهد ، وهكذا تكون الأنبياء وأولاد الأنبياء)(٢٩٤) .
٣ ـ عن أنس بن مالك : (أنّ عظيماً من عظماء الملائكة ، إستأذن ربّه عَزّ وجَلّ في زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأذن له ، فبينما هو عنده ، إذ دخل عليه الحسين عليه السلام ؛ فقبّله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأجلسه في حجره ، فقال له الملك : أتحبه؟ قال : أجل أشدّ الحبّ ، إنه ابني. قال له : إنّ أمّتك ستقتله. قال : أمّتي تقتل ابني هذا؟ قال نعم ، وإن شئت أريتك من التربة التي يقتل عليها ، قال : نعم. فأراه تربة حمراء طيّبة الريح ، فقال : إذا صارت هذه التربة دماً عبيطاً ؛ فهو علامة قتل ابنك هذا. قال سالم بن أبي الجعد : أخبرت أنّ الملك كان ميكائيل)(٢٩٥) .
٢٨ ـ مَشْهَد الحسين (عليه السلام) :
المشهد : «المجمع من الناس. محضر الناس ، ومشاهد مكة ؛ المواطن التي يجتمعون بها»(٢٩٦) . «وجمع مشهد ، مشاهد ، ومنه مشاهد الحج ؛ وهي مواطنه الشريفة التي يحضرها الملائكة والأبرار من الناس»(٢٩٧) .
__________________
(٢٩٤) ـ المصدر السابق / ١٧٧ ، (عن أمالي الصدوق ، المجلس ٨٧ ـ الحديث ٥).
(٢٩٥) ـ نفس المصدر / ١٦٣ ، (عن أمالي الطوسي / المجلس ١١ ـ الحديث ٨٦).
(٢٩٦) ـ ابن منظور ، محمد مكرم : لسان العرب ، ج ٣ / ٢٤١.
(٢٩٧) ـ الراغب الأصفهاني ، الحسين بن محمد : المفردات في غريب القرآن ، ج ١ / ٣٥٣.
وفي مصطلح الإمامية الإثني عشرية يُطلق على : موضع الشهادة ، ومحل الدفن ، والحرم للأئمة المعصومين عليهم السلام ، أو الأولياء من أبنائهم وأصحابهم الأتقياء ؛ ولذا أطلق على البقعة التي إستشهد عليها الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه (مشهد الحسين) ، وقد أشارت إلى ذلك الروايات التالية :
١ ـ قال الحر العاملي : روى صاحب كتاب (مناقب فاطمة) : بإسناده عن إبراهيم بن سعيد : (أنّ الحسين عليه السلام قال لزهير : أعلم أنّ ها هنا مشهدي ، ويحمل هذا عن جسدي ـ يعن رأسه ـ زحر بن قيس ، ويدخل على يزيد ويرجو نائله ، فلا يعطيه شيئاً) (٢٩٨).
٢ ـ روى المجلسي (ره) في البحار في حديث الحسين عليه السلام مع أم سلمه (رض) : (ثم أشار عليه السلام إلى جهة كربلاء فانخفضت الأرض حتى أراها مضيجعه ومدفنه وموضع عسكره ، وموقفه ومشهده ، فعند ذلك بكت أم سلمة بكاء شديداً وسلمت أمره إلى الله ، فقال لها : يا أماه ، قد شاء الله عَزّ وجَلّ أن يراني مقتولاً مذبوحاً ، ظلماً وعدواناً. وقد شاء أن يرى حرمي ورهطي ونسائي مشرّدين وأطفالي مذبوحين مظلومين ، مأسورين مقيدين ، وهم يسستغيثون فلا يجدون ناصراً ولا معيناً)(٢٩٩) .
٢٩ ـ مُقَدّسَةٌ مباركة :
ذكر هذا الاسم في الحديث التالي :
عن عمرو بن ثالت ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : (خلق الله أرض كربلاء قبل أن يخلق أرض الكعبة بأربعة وعشرين ألف عام ، وقَدّسها
__________________
(٢٩٨) ـ الحر العاملي ، الشيخ محمد بن الحسن : إثبات الهداة ، ج ٥ / ٢٠٦.
(٢٩٩) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٤٤ / ٣٣١.
وبارك عليها ، فما زالت قبل خلق الله مُقَدّسَة مباركة ، لا تزال كذلك حتى يجعلها الله أفضل أرض في الجنة ، وأفضل منزل ومسكن يُسكن الله فيه أولياءه في الجنة)(٣٠٠) .
٣٠ ـ مكاناً قَصِيا :
عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين عليه السلام في قوله : ( فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ) (٣٠١) . (قال : خرجت من دمشق حتى أتت كربلاء ، فوضعته في موضع قبر الحسين (عليه السلام) ، ثم رجعت في ليلتها)(٣٠٢) .
هذا الحديث خلاف ما جاء عن المفسرين في مكان ولادتها بعيسى عليه السلام ؛ حيث ذهبوا إلى ما يلي :
أ ـ العامة :
ذهب المفسرون منهم إلى أنّ الربوة أرض بيت المقدس ؛ فإنّها مرتفعة ، أو دمشق ، أو رملة فلسطين ، أو مصر. وقالوا : (ذات قرار) ؛ أي مستقر من الأرض منبسطة. وقيل : ذات ثمار وزروع ، فإنّ ساكنيها يستقرُّون فيها لأجلها. ويقال ماء معين ظاهر جار.
ب ـ الخاصة :
المستفاد من روايات أهل البيت عليهم السلام هو التالي :
«وقال علي بن إبراهيم في قوله عَزّ وجَلّ : ( وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً ) إلى قوله ( وَمَعِينٍ ) ، قال : الربوة الحيرة ، وذات قرار ومعين الكوفة. وفي مجمع
__________________
(٣٠٠) ـ النوري ، ميرزا حسين الطبرسي : مستدرك الوسائل ، ج ١٠ / ٣٢٢. (باب ٥١ من أبواب المزار ـ حديث ٢).
(٣٠١) ـ مريم / ٢٢.
(٣٠٢) ـ الطوسي ، الشيخ محمد بن الحسن : تهذيب الأحكام ، ج ٦ / ٧٣.
البيان ( وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ) ، وقيل : حيرة الكوفة وسوادها والقرار مسجد الكوفة ، والمعين الفرات. عن أبي جعفرو أبي عبد الله (عليهما السلام)(٣٠٣) .
عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عَزّ وجَلّ : ( وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ) . قال : الربوة ؛ نجف الكوفة ، والمعين ؛ الفرات)(٣٠٤) .
عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص قال : (رأيت أبا عبد الله عليه السلام يتخلل بساتين الكوفة فإنتهى إلى نخلة فتوضأ عندها ثم ركع وسجد ، فأحصيت في سجوده خمسمائة تسبيحة ، ثم استند إلى النخلة فدعا بدعوات ، ثم قال : يا حفص إنها والله ال نخلة التي قال الله جلّ ذكره لمريم (عليها السلام) : ( وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ) (٣٠٥) . وبعد هذا البيان نقول : لا غرابة ولا إستبعاد في ولادتها بعيسى عليه السلام في كربلاء ؛ إذ بعض الروايات تَنصّ وتشير إلى ذلك ، ويؤيد ذلك الفيض الكاشاني (قده) بقوله : « ( فَحَمَلَتْهُ ) ؛ يعني مريم ، عيسى (عليهما السلام) ، ( مَكَانًا قَصِيًّا ) ؛ أي بعيداً ، وقد مضى ما يؤيد هذا الحديث في باب فضل الفرات»(٣٠٦) .
__________________
(٣٠٣) ـ الحويزي ، الشيخ عبد علي جمعة : نور الثقلين / ج ٥ / ٩٠.
(٣٠٤) ـ الكليني ، الشيخ محمد بن يعقوب : الكافي ، ج ٨ / ١٢٦.
(٣٠٥) ـ الفيض الكاشاني ، الشيخ محمد حسن : الوافي / ج ١٤ / ١٥٢٣.
(٣٠٦) ـ نفس المصدر.
الفصل الثاني
أسماء تاريخية
١ ـ أرض بابل
٢ ـ أرض العراق
٣ ـ شُفَيّة
٤ ـ العَقر
٥ ـ عَمُورَا
٦ ـ الغَاضِرِيّة
٧ ـ نِيْنَوَى
٨ ـ النواويس
٩ ـ المقدفان
١ ـ أرض بابل :
منطقة تاريخية تقع بين نهري دجلة والفرات ـ بلاد ما بين النهرين ، ووادي الرافدين ـ إزدهرت فيها حضارات السومريين ، والآشوريين ، والبابليين ، فكربلاء تقع شرق مدينة بابل الأثرية ، وهي تابعة لأرض بابل. يقول الشيخ محممد باقر المدرس في كتابه (مدينة الحسين عليه السلام) : «لو أننا رجعنا إلى تاريخ هذه المدينة إلى عهد البابليين ؛ لوجدنا لها إسماً وأثراً ؛ لأنّه بناء على ما قاله المستشرق الفرنسي ماسينسيون في كتابه (خطط الكوفة ـ ترجمة تقي المصعبي ـ : إنّ كربلاء كانت معبد الكلدانيين الذين كانوا يقطنون في مدينة نينوى ، والصقر البابلي ، وكلاهما كان بقرب كور بابل»(٣٠٧) .
ويقول الخليلي في (موسوعة العتبات المقدسة) : «نينوى : كورة كانت بأرض بابل ، منها كربلاء التي قتل فيها الحسين»(٣٠٨) .
وقد ورد ذكر هذا الإسم في الرواية التالية :
روى ابن عساكر : (أنّ عمرة بنت عبد الرحمن(٣٠٩) ، كتبتب إلى الإمام عليه السلام تعظم عليه ما يريد أن يصنع من إجابة أهل الكوفة ، وتأمره بالطاعة ولزوم
__________________
(٣٠٧) ـ الطبسي ، الشيخ محمد جعفر : مع الركب الحسيني ، ج ٤ / ١٩.
(٣٠٨) ـ الخليلي ، جعفر : موسوعة العتبات المقدسة ، ج ١٣ / ١٥.
(٣٠٩) ـ عَمْرَة بنت عبد الرحمن ، بن أسعد ، بن زرارة الأنصارية النجارية (٢١ هـ ـ ٩٨ هـ) ، فقهية ، وهي تلميذة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وربيت على يديها ، وكان أبوها وجدها من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، قال القاسم بن محمد ، لابن شهاب : يا غلام أراك تحرص على طلب العلم؟ أفلا أدلك على وعائه؟ فقال : بلى. قال عليك بعمرة ، فإنها كانت في حجر السيدة عائشة ، راجع الموسوعة العربية العالمية ، ج ١٦ / ٦٤٢ «بتصرف».
الجماعة ، وتخبره أنه إنما يُساق إلى مصرعه ، وتقول : أشهد لحدثتني عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : (يقتل حسين بأرض بابل)(٣١٠) .
٢ ـ أرض العراق :
قال الشيخ الطريحي (ره) : «والعراق ، ككتاب ، بلاد تُذكّر وتونث. قيل : سميت بذلك في اللغة شاطئ النهر والبحر. وهي واقعة على شاطئ دجلة والفرات ، والعراقان : الكوفة والبصرة»(٣١١) ، وتسمى بـ(أرض السواد) : وهي الأرض العامرة قبل الفتح الإسلامي ؛ وسميت هذه الأرض سواداً ؛ لأنّ الجيش لما خرجوا من البادية ، ورأوا هذه الأرض وإلتفاف شجرها سموها السواد لذلك. ومن هذه الأرض كربلاء التي قتل فيها الحسين عليه السلام. وذكر هذا الإسم في الروايات التالية :
١ ـ عن سحيم(٣١٢) ، عن أنس بن الحارث (رض) قال : (سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : إنّ إبني هذا يقتل بأرض العراق ، فمن أدركه فلينصره)(٣١٣) .
٢ ـ عن عبد الله بن وهب بن زمعه قال : أخبرتني أم سلمة (رضي الله عنها) : «إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إضطجع ذات ليلة للنوم فاستيقظ وهو خائر ، ثم إضطجع فرقد ثم استيقظ وهو خائر دون ما رأيت به المرة الأولى ، ثم إضطجع فاستيقظ وفي يده تربة حمراء يقبلها فقلت : ما هذه التربة يا رسول الله؟ قال : أخبرني جبريل (عليه الصلاة والسلام) : أنّ هذا يقتل بأرض
__________________
(٣١٠) ـ الطبسي ، الشيخ محمد جعفر : مع الركب الحسيني ، ج ٤ / ٢٧.
(٣١١) ـ الطريحي ، الشيخ فخر الدين : مجمع البحرين ، ج ٥ / ٢١٣ ـ ٢١٤.
(٣١٢) ـ وفي البحار / ج ٤٤ / ٢٤٧ (عن أنس بن أبي سحيم).
(٣١٣) ـ أبو نعيم ، أحمد بن عبد الله : دلائل النبوة ، ج ٢ / ٥٥٤ ـ حديث رقم ٤٩٣.
العراق ـ للحسين ـ. فقلت لجبريل : أرني تربة الأرض التي يقتل بها ، فهذه تربتها فقال : هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»(٣١٤) .
٣ ـ «ووجدت في بعض الكتب أنه عليه السلام لما عزم على الخروج من المدينة أتته أمُّ سلمة (رضي الله عنها) فقال : يا بني ، لا تحزني بخروجك إلى العراق ، فإني سمعت جَدك يقول : يقتل ولدي الحسين بأرض العراق ، في أرض يقال لها كربلاء ، فقال لها : يا أماه ، وأنا والله أعلم ذلك وإني مقتول لا محالة ، وليس لي من هذا بدُّ ، وإني والله لأعرف اليوم الذي أقتل فيه ، وأعرف من يقتلني ، وأعرف البقعة التي أُدفن فيها ، واني أعرف من يُقتل من أهل بيتي وقرابتي وشيعتي ، وإن أردت يا أماه أريكِ حفرتي ومضجعي»(٣١٥) .
٣ ـ شُفَيّة :
«وهي بئر حفرتها بنو أسد بالقرب من كربلاء ، وأنشأت بجانبها قرية»(٣١٦) .
ويرى العلامة المظفر (ره) ـ وخلاصة ما حققه ـ ما يلي :
«ولم يضبط لفظها ضبطاً دقيقاً ، فإنّها وردت في حديث نزول الحسين عليه السلام بكربلاء ، وسَمّاها بعضهم السقبة بالسين المهملة ، والقاف المنقطة بنقطتين ، ثم الباء المنقطة بواحدة من تحت ، ومن هؤلاء الدينوري.
ومنهم من سماها الشفية بالشين المعجمة المنقطة بثلاث ثم فاء منقطة بواحدة ، ثم ياء منقطة باثنين ، ومن هؤلاء الطبري المؤرخ ، وهذا لفظة
__________________
(٣١٤) ـ الحاكم ، محمد بن عبد الله النيسابوري : مستدرك الصحيحين ، ج ٤ / ٣٩٨.
(٣١٥) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٤٤ / ٣٣١.
(٣١٦) ـ آل طعمة ، السيد سلمان هادي : تراث كربلاء / ٢٠ وأيضا النهاية في غريب الحديث ، ج ٢ / ٤٨٨ لإبن الأثير.
ص / ٢٣٣ ، ج ٦ : «وأخذ الحر بن يزيد القوم بالنزول في ذلك المكان على غير ماء ، ولا قرية ، فقالوا : دعنا ننزل في هذه القرية ؛ يعنون نينوى ، أو هذه القرية ؛ يعنون الغاضرية ، أو هذه الأخرى ؛ يعنون شفية. فقال : لا والله لا أستطيع ذلك ، هذا رجل قد بعث عليناً عليّ إلخ). وهو بعينة لفظ الشيخ المفيد في الإرشاد ص / ٢٣٨. وتبعه الملا عبد الله في مقتل العوالم ص / ٧٤ ، والفاضل المجلسي في البحار ص / ١٩٨ ، ج ١٠ ، وعبد الرحيم اليزدي في مصائب المعصومين ص / ٢٣١ ، وجميع هؤلاء يُصرّح أنّ الحسين عليه السلام كان يمتنع على الحر مرة ويسايره أخرى ، حتى إنتهى إلى نينوى ، المكان الذي نزل به الحسين عليه السلام ، وهذا هو القول الصحيح ـ إلى أن قال ـ : وعلى كل فشفية من قوى كربلاء وإن أهملها أكثر أهل المقاتل وأهملها الحموي ، ولكن أثبتها من ذكرنا من أعيان العلماء ، وذكرها أيضا ابن الأثير في تاريخه ص / ٢٦ ، ج ٤ ، طبعة الأولى»(٣١٧) .
وذكر بعض أصحاب المقاتل ما يلي :
«وإنّ الضحاك بن عبد الله المشرفي ، عندما إشتد الأمر على الحسين عليه السلام يوم عاشوراء وبقي وحيداً ، إستأذن الحسين عليه السلام بالإنصراف لوعد كان بينهما ـ أنه ينصره متى كان كثير الأنصار ـ ، فاستوى على ظهر فرسه فوجهها نحو العسكر ، فأفرجوا وإخترق صفوفهم ، ثم تبعه منهم خمسة عشر فارساً حتى جاء شفية ، فالتجأ بها وسلم من القتل»(٣١٨) .
__________________
(٣١٧) ـ المظفر ، الشيخ عبد الواحد : البطل العلقمي ، ج ٣ / ٣٧٤ ـ ٣٧٦. (بتصرف)
(٣١٨) ـ آل طعمة ، السيد سلمان هادي : تراث كربلاء / ٢٠ ـ ٢١.
٤ ـ العَقْر :
قال ياقوت الحموي : «العقر : بفتح أوله وسكون ثانية ، قال الخليل : سمعت أعرابياً من أهل الصَمّان يقول : كل فرجه تكون بين شيئين فهو عَقْرٌ لغتان. وقال غيره : العقر القصر على أي حال كان ، والعقر الغمام ، والعقر : عدة مواضع منها : عقر بابل قرب كربلاء من الكوفة. وقد روي : أنّ الحسين (رضي الله عنه) لما إنتهى إلى كربلاء وأحاطت به خيل عبيد الله من العقر قال : ما اسم تلك القرية؟ وأشار إلى العقر فقيل له : اسمها العقر. فقال : نعوذ بالله من العقر ، فما إسم هذه الأرض التي نحن فيها؟ قالوا : كربلاء ، قال أرض كرب وبلاء ، وأراد الخروج منها فمنع حتى كان ما كان. قتل عنده يزيد بن المهلب بن أبي صفرة في سنة ١٠٢ هـ ، وكان خلع طاعة بني مروان ودعا إلى نفسه إلخ»(٣١٩) .
ولكن العلامة الشيخ عبد الواحد المظفر (ره) يرى خلاف ذلك ، وخلاصة ما ذهب إليه ما يلي :
«هنا قريتان : عقر كربلاء وعقر بابل أو عقر الملك ـ كما سَمّاها الطبري ـ واختلط على ياقوت الحموي ومقلديه ، فخلطوا بين العقرين ، وأنا أقوم إن شاء الله بإيضاح هذا الغلط وأقيم الأدلة كالتالي :
إنّ عقر بابل محاط بأنهار ومياه ، وعقر كربلاء محاط بمفازة وبيداء ، سوى نهر يمر بها يسقي بساتينها ، وللتفرقة بينهما أمور :
أحدها ـ كثرة المياه في الموضع الذي قتل فيه ابن المهلب ، لما ذكر في مقتله من كثرة الجسور ، ولو كان في البقعة التي استشهد عندها الحسين عليه السلام
__________________
(٣١٩) ـ الحموي ، شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت : معجم البلدان ، ج ٤ / ١٣٦.
جسور على أنهار ؛ لما عطش الحسين عليه السلام وإنما عطش ؛ لأنّ في كربلاء نهر واحد صغير نزل على ضفته الأعداء ، وأوثقوا الإستحكام على شرائعه ؛ وذلك لا يكون أكبر من نهر الحسينية بكثير ، ولو أحرق جسره أو قطع لا يعوق المنهزم لإمكان خوضه وسعة البادية في جانبيه ، بخلاف العقر الذي تحيط به أنهار كثيرة بحيث تمنع المنهزم بغزارة مائها وكثرتها ، أما جدول العلقمي وفروعه الصغيرة ، لا تصد منهزماً ، ولا تحول بينه وبين الفرا ، لسهولة خوضه واقتراب ضفتيه بعضها من بعض.
ثانيهما ـ إنّ مسير ابن المهلب كان من واسط أو قضاء الحي الحالي إلى العقر ، على الطريق الذي يوصل إلى الحلة من طريق عفك ، والدغارة ، فالديوانية ، فأراضي الشافعية ، فعقر بابل.
ثالثهما ـ الحرس الذي أقامه بنو أمية في النخيلة (جسر العباسيات) يمنع أهل الكوفة من نجدة ابن المهلب يُعيِّن أن مقتله في عقر الشامية ؛ لأن طريق من أنجده من أهل الكوفة النخيلة ، ولو كانت عقر كربلاء لتركوا طريق النخيلة وتسربوا إلى نجدته من الظهر ـ ظهر الكوفة ـ النجف الأشرف على موضع خان الحماد ، أو خان جضعان فذاك مسلك فسيح ، وطريق واسع لا تتسلط عليه قوة الحرس الذي بالنخيلة.
رابعها ـ أنّ العباس ابن الوليد أحد قواد جيش بني أمية نزل بسورا ، وسورا هي الهاشمية أو الجربوعية الحالية ، وفراتها يسمى لذلك نهر سورا ، وتطلق سورا على كافة أراضي العذار ، فإذا كان جيش بني أمية في الهاشمية فابن المهلب في عقر الهاشمية ، وما أبعد ما بين الجربوعية وكربلاء في جيشين ملتحمين في الحرب.
خامسها ـ إنّ قائد القوات الأموية الأول مسلمة بن عبد الملك المرواني بعد ظفره بابن المهلب ، عاد فنزل الحيرة والطريق من الشامية إلى الحيرة أو الجعارة على أبي صخير معروف ، ولو كان من كربلاء لما تجاوز الكوفة.
سادسها ـ إنّ قواد بني أمية ، لما أقبلوا لحرب ابن المهلب ، أقبلوا على خط الفرات من هيت ، وعانة ، فالرمادي ، إلى الأنبار فعقدوا الجسر وعبروا منه إلى الجزيرة ، ولو كان مركز ابن المهلب في كربلاء ، ما احتاجوا إلى عقد جسر ، وساروا على ضفاف الفرات الغربي ، حتى يصلوا إلى كربلاء ، فأي فائدة في هذا العناء بعقد جسر ليعبروا منه ، ثم يعقدوا مرة أخرى جسراً يعبروا به إلى ملاقات عدوهم ، كل هذه المرجحات يستبين منها جلياً ، أنّ عقر التي قتل عندها ابن المهلب ؛ هي عقر المهناوية لا عقر الطفوف ، وهذا اسمها إلى اليوم عقر (عكر) ، وهي مشهورة بغزارة المياه ، وجودة الأرز ، وكثرة الصيد من أسماك وطيور ، وهي تابعة لقضاء الشامية ، لواء الديوانية ، وهي كثيرة المياه صالحة لأن تعقد عليها جسور كثيرة»(٣٢٠) .
والروايات التي ذكرت (العقر) منها ما يلي :
«وفي رواية : قال زهير : سر بنا إلى هذه القرية حتى ننزلها فإنّها حصينة ، وهي على شاطئ الفرات ، فإن منعونا قاتلناهم فقتالهم أهون علينا من قتال من يجي بعدهم ، فقال عليه السلام : وما هي؟ قالوا : هي العقر. فقال : اللهم إني أعوذ بك من العقر»(٣٢١) .
__________________
(٣٢٠) ـ المظفر ، الشيخ عبد الواحد : البطل العلقمي ، ج ٣ / ٣٦٢ ـ ٣٦٤.
(٣٢١) ـ إعداد لجنة الحديث ، معهد تحقيقات باقر العلوم : موسوعة كلمات الإمام الحسين (ع) / ٣٧٤.
٥ ـ عَمُورَا :
لعل سبب تسميتها بهذا الإسم يرجع إلى ما يلي :
١ ـ أن تكون راجعة إلى العِمَارة) ، فهذه البقعة من الأرض مرت بحضارة ما بين النهرين ، فهي عامرة من قديم الزمان ، بل كانت مقبرة للبابليين ؛ ولذا أطلق عليها النواويس ، وفي حديث أمير المؤمنين عليه السلام ، لما مَرّ بـ(المقدفان) قال : (... قتل فيها مائتا نبي ، ومائتا سيط كلهم شهداء) ، إذن أرض كربلاء عامرة منذ قديم الزمان ؛ ولذا سميت بـ(عمورا).
٢ ـ أن تكون راجعة إلى (الإعمار) ؛ أي الزيارة ، فهي محل للزيارة والتقديس من قديم الزمان ، فالمستفاد من الروايات أن الأنبياء مروا على هذه البقعة الطاهرة ، وأخبروا من قبل الوحي بما سيحل على الحسين عليه السلام في هذه البقعة ولعنوا قاتليه ، وإلى هذا تشير رواية خالد الربعي قال : حدثني مع سمع كعباً يقول : (أوّل من لعن قاتل الحسين بن علي عليه السلام إبراهيم خليل الرحمن ، وأمر ولده بذلك ، وأخذ عليهم العهد والميثاق ، ثم لعنه موسى بن عمران ، وأمر أمته بذلك ، ثم لعنه داود ، وأمر بني إسرائيل بذلك ، ثم لعنه عيسى وأكثر أن قال : يا بني إسرائيل إلعنوا قاتله ، وإن أدركتم أيامه فلا تجلسوا عنه ، فإن الشهيد معه كالشهيد مع الأنبياء ، مقبلٍ غير مُدبر ، كأني أنظر إلى بقعته ، ما من نبي إلا وقد زار كربلاء ، ووقف عليها ، وقال : إنك لبقعة كثيرة الخير ، فيك يدفن القمر الأزهر)(٣٢٢) .
وبعد مقتل الحسين عليه السلام أضحت مزاراً للملائكة ولسائر البشر ، وقد ذكر هذا الإسم في الرواية التالية :
__________________
(٣٢٢) ـ المصدر السابق / ٣٠١ (حديث ـ ١٠).
عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال الحسين عليه السلام لأصحابه قبل أن يقتل : (إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لي : يا بني ، إنك ستساق إلى العراق ، وهي أرض قد إلتقى بها النبيون وأوصياء النبيين ، وهي أرض تدعى عمورا ، وأنك تستشهد بها ، ويشتهد معك جماعة من أصحابك ، لا يجدون ألم مسّ الحديد ، وتلا : ( قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ) (٣٢٣) يكون الحرب برداً وسلاماً عليك وعليهم ، فأبشروا فوالله لئن قتلونا فإنّا نرد على نبينا)(٣٢٤) .
٦ ـ الغَاضِريّة :
من القرى العامرة عند نزول الحسين عليه السلام بكربلاء ومن أقربها إلى محل نزوله بعد نينوى ، وينبغي بحثها من ناحيتين :
الأولى ـ في أقوال الباحثين :
قال ياقوت الحموي : «الغاضرية : بعد الألف ضاد معجمة ، منسوبة إلى غاضرة من بني أسد : وهي قرية من نواحي الكوفة قريبة من كربلاء»(٣٢٥) .
وقال الدكتور سلمان آل طعمة : «وجاء في (مدينة الحسين) : الغاضريات نسبة إلى غاضرة ، وكلمة غاضرة هي اسم لامرأة من بني عامر ، وهي بطن من بني أسد ، كانوا يسكنون هذه الأراضي التي تقع اليوم شمال الهيابي ، التي فيها مصانع للآجر ، وتبعد عن كربلاء ، أقل من نصف كيلومتر. وكانت قرية عامرة كبيرة تمتد على ضفة الفرات ، في شمال كربلاء إلى شمالها الشرقي ، أي على طريق بغداد القديم»(٣٢٦) .
__________________
(٣٢٣) ـ الأنبياء / ٦٩.
(٣٢٤) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٤٥ / ٨٠ ـ ٨١.
(٣٢٥) ـ الحموي ، شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت : معجم البلدان ، ج ٤ / ١٨٣.
(٣٢٦) ـ آل طعمة ، السيد سلمان هادي : تراث كربلاء / ٢٠ ـ ٢١.
وقال العلامة الشيخ عبد الواحد المظفر (ره) : «وقد يراها بعض المحققين أنها أراضي الحسينية ، أو على مقربة من خان العطيشي ، مركز ناحية الحسينية الحالي. ويَعرِّفها البَحّاتة الشهرستاني بأراضي الحسينية ؛ يعني بها المقاربة لخان العطيشي. لكني أجزم أنّها الأراضي الجنقنة فما دونها إلى بلدة كربلاء ، وقد صَرّح لي أبو حنيفة أحمد ابن ثابت الدينوري ـ وهو من علماء الدغرافية ـ أنّها بمقدار غلوة من منزل الحسين عليه السلام ، والغلوة ـ في لسان العرب ـ رمية سهم ، فإن كانت الغلوة رمية سهم أو ثلثمائة ذراع ؛ فهي لا شك باب البلدة المعروفة بباب الحسينية ، قرب مرقد سيدنا العباس بن أمير المؤمنين عليه السلام ، واعتراض خيل ابن سعد لهم في الطريق لا يتفق مع هذا ، وعلى هذا فيمكن الجمع بأن يقال ، أقرب حدود أراضي الغاضرية إلى منزل الحسين عليه السلام هو الغلوة ، وأقصاها ما يقارب خان العطيشي ، فمن المسنات مرقد العباس عليه السلام ، إلى القنطرة البيضاء ، إلى خان العطيشي ، ومركز القرية الأعظم يكون في وسط هذه الأراضي ، وإليه قصد حبيب بن مظاهر ، لما دعاهم لنصرة الحسين عليه السلام ...»(٣٢٧) .
الثانية ـ في الروايات :
وبعد التعريف والوصف التاريخي لها ، نذكر بعض الروايات التي نصّت عليها كالتالي :
١ ـ قال أبو جعفر عليه السلام : (الغاضرية : هي البقعة التي كَلّم الله فيها موسى بن عمران ، وناجى نوحاً فيها ، وهي أكرم أرض الله عليه ، ولولا ذلك ما استودع الله فيها أولياءه وأنبياءه ، فزوروا قبورنا بالغاضرية)(٣٢٨) .
__________________
(٣٢٧) ـ المظفر ، الشيخ عبد الواحد : البطل العلقمي ، ج ٣ / ٣٥٠ ـ ٣٥١.
(٣٢٨) ـ النوري ، ميرزا حسين الطبرسي ، مستدرك الوسائل ، ج ١٠ / ٣٢٤. (باب ٥١ من أبواب المزار ـ حديث ٥).
٢ ـ وقال أبو عبد الله عليه السلام : (الغاضرية من تربة بيت المقدس)(٣٢٩) .
٣ ـ عن أبي حمزة الثمالي : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (إذا أردت الوداع بعد فراغك من الزيارات فأكثر منها ما استطعت ، وليكن مقامك بالنينوى أو الغاضرية)(٣٣٠) .
٤ ـ في الإرشاد : «وأخذهم الحرّ بالنزول في ذلك على غير ماء ولا قرية ، فقال له الحسين عليه السلام دعنا ـ ويحك ـ ننزل في هذه القرية أو هذه ؛ يعني نينوى أو الغاضرية ، أو هذه ؛ يعني شِفْتَة قال : لا والله ما استطيع ذلك ، هذا رجل قد بعث إليّ عيناً عليّ»(٣٣١) .
٧ ـ نِيْنَوَى :
من الأسماء القديمة للبقعة الطاهرة (نينوى) ، وهي قرية من قرى كربلاء ، وكانت عامرة وقت نزول الحسين عليه السلام ، وقد إعتنى بها الباحثون كالتالي :
قال ياقوت الحموي : «نِيْنوى : بكسر أوله وسكون ثانية وفتح النون والواو بوزن طِيطَوى : وهي قرية يونس بن متى عليه السلام بالموصل ؛ وبسواد الكوفة ناحية يقال لها نِينَوى ، منها كربلاء التي قتل بها الحسين ، رضي الله عنه»(٣٣٢) .
وقال الدكتور سمان آل طعمة : «نينوى : تقع شرقي كربلاء ؛ وهي سلسلة تلول أثرية تمتد من جنوب سدة الهندية حتى مصب نهر العلقمي في الأهوار ، وتعرف بتلول نينوى ، وكانت إذا قرية عامرة ززاهرة بالعلوم والمعارف في عهد الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ، ومن أبرز علمائها
__________________
(٣٢٩) ـ المصدر السابق.
(٣٣٠) ـ ابن قولويه ، الشيخ جعفر بن محمد : كامل الزيارات / ٤٣٧ ، (باب ٨٤ ـ حديث ٢).
(٣٣١) ـ المفيد ، الشيخ محمد بن محمد النعمان : الإرشاد ، ج ٢ / ٨٤.
(٣٣٢) ـ الحموي ، شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت : معجم البلدان ، ج ٥ / ٣٣٩.
الفطاحل أبو القاسم حميد بن زياد النينوي ، وكان اسم كربلاء يطلق على نينوى ، واسم هذه على تلك على حد سواء. ويروي الطبري ، وابن الأثير عن نزول الحسين عليه السلام أرض كربلاء فقالا : فلما أصبح ـ أي الحسين عليه السلام ـ نزل فصلّى الغداة ، ثم عَجّل بالركوب ، وأخذ يتياسر بأصحابه يريد أن يفرقهم ، فيأتيه الحر بن يزيد فيردهم فيرده ، فجعل إذا رَدّهم إلى الكوفة رداً شديداً امتنعوا عليه فارتفعوا ، فلم يزالوا يتياسرون ، حتى انتهوا إلى نينوى ، المكان الذي نزل به الحسين»(٣٣٣) .
وقد أشارت الروايات إلى هذا الاسم كما يلي :
١ ـ عن ابن عباس قال : (كنت مع أمير المؤمنين عليه السلام في خرجته إلى صفين ، فلما نزل بنينوى ـ وهو بشط الفرات ـ قال بأعلى صوته : يا ابن عباس ، أتعرف هذا الموضع؟ قلت له : ما أعرفه يا أمير المؤمنين. فقال عليه السلام لو عرفته كمعرفتي لم تكن تجوزه حتى تبكي كبكائي إلخ)(٣٣٤) .
٢ ـ روي : (أنّ الحسين عليه السلام إشترى النواحي التي فيها قبره من أهل نينوى ، والغاضرية بستين ألف درهم ، وتصدّق عليهم ، وشرط أن يرشدوا إلى قبره ، ويضيِّفوا من زاره ثلاثة أيام) وذكر السيد رضي الدين ابن طاووس : «أنها إنما صارت حلالاً بعد الصدقة ؛ لأنهم لم يفوا بالشرط ، قال : وقد روى محمد بن داود عدم وفائهم بالشرط في باب نوادر الزيارات»(٣٣٥) .
__________________
(٣٣٣) ـ آل طعمة ، السيد سلمان هادي : تاريخ مرقد الحسين والعباس / ٢٢ ـ ٢٣.
(٣٣٤) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٤٤ / ٢٥٢.
(٣٣٥) ـ النوري ، ميرزا حسين الطبرسي ، مستدرك الوسائل ، ج ١٠ / ٣٢١ ، (باب ٥٠ من أبواب المزار ـ حديث ٧).
٣ ـ وعن عبد الله بن يحيى قال : (دخلنا مع علي إلى صفين ، فلما حاذى نينوى ؛ نادى صبراً يا أبا عبد الله ، فقال : دخلت على رسول الله وعيناه تفيضان فقلت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما لعينيك تفيضان؟ أغضبك أحد؟ قال : لا ، بل كان عندي جبرئيل فأخبرني أنّ الحسين يقتل بشاطئ الفرات ، وقال : هل لك أن أشمّك من تربته؟ قلت : نعم ، فمدّ يده فأخذ قبضة من تراب فأعطانيها ، فلم أملك عيني أن فاضتا إلخ)(٣٣٦) .
٨ ـ النواويس :
من الأسماء القديمة لهذه البقعة الطاهرة «النواويس» ، وقد اهتم به المؤرخون والباحثون كما يلي :
قال الدكتور سلمان آل طعمة : «النواويس : وهي الآن مقابر ، مفردها ناووس على وزن فاعول ، واللفظة من الدخيل. وهذه القطعة واقعة شرقي كربلاء ، مما يلي بحيرة السليمانية ، في محل يقال له (براز علي) وزن ذهاب ، وتتصل بنهر الحسينية ، وتوجد في هذه القطعة الآثار المؤيدة بصحة موقعها ووجودها ؛ كالتلال والروابي والمرتفعات ، ويستخرج منها أحياناً توابيت الخزف ، وفي داخلها طريق ضيق للغاية ، ويجد في قصره تراب أصفر اللون ، يرميه العرب في النار فتفوح منه رائحة كريهة ، يشمها الإنسان من مكان بعيد ، وهذا ما يقوي إستدلالنا على وجود هذه البلدة أو القرية في عهد علي عليه السلام ، ولعل الرائحة التي تشم من ذلك التراب حين رميه بالنار ، تنبئنا بأنها أجساد بالية قديمة»(٣٣٧) .
__________________
(٣٣٦) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٤٤ / ٢٤٧ ـ ٢٤٨.
(٣٣٧) ـ آل طعمة ، السيد سلمان هادي : تاريخ مرقد الحسين والعباس / ٢٣ ـ ٢٤.
وقال أيضاً : «وكانت مقبرة عامة قبل الفتح الإسلامي ، وتقع في أراضي ناحية الحسينية قرب نينوى. أما الأطلال الكائنة في شمال غربي كربلاء ؛ تعرف بـ(كربلاء القديمة) ، يستخرج منها أحياناً بعض الحباب الخزفية ، وكان البابليون يدفنون موتاهم فيها»(٣٣٨) .
وقال العلامة الشيخ عبد الواحد المظفر (ره) : «هي مقبرة الحر الشهيد الرياحي وفيها مرقده ، وكانت مقبرة قديمة ، وفي دفن هذا البطل المجاهد إلى هذا الموضع النائي عن مرقد الشهداء أقوال :
١ ـ قول أنه سقط هناك فلم يحمل إلى خيمة القتلى من الشهداء ، لحيلولة القوم بينهم وبينه ، مع إشتغالهم بالحرب.
٢ ـ وقول أنّ عمر بن سعد لما أمر بقطع رؤوس الرؤساء من أنصار الحسين عليه السلام ، أبت بنو تميم أن يقطع راس الحر ، فحملوه ودفنوه هناك.
٣ ـ ويقال : إنما حملوه ؛ لأنّ عمر بن سعد أمر بوطئ جثت القتلى إمتثالاً لأمر ابن زياد ، فقامت بنو تميم وحامت عنه ومنعت منه ، ثم حملته إلى هذا الموضع ، ومنعت كل قبيلة من وطئ جثت رجالها ، لكنهم لم يحملوهم ولم يدفنوهم. وهذا ضعيف ؛ لأنّ المأمور به ابن سعد ، وطئ جسد الحسين عليه السلام خاصة ، فوطئته الخيل دون سائر الشهداء من العلويين وغيرهم ، كما صَرّحت بذلك الكتب والمقاتل.
__________________
(٣٣٨) ـ آل طعمة ، السيد سلمان هادي : تراث كربلاء / ٢٠.
٤ ـ وهناك قول آخر يعد رابعاً : أنّ الإمام زين العابدين عليه السلام ، أمر بني أسد بنقله إلى هناك ، وهذا بعيد جداً. وكيف كان الأمر ، فموضع قبر الحر كان مقبرة للأنباط والمسيحيين قديمة قبل الفتح الإسلام بكثير»(٣٣٩) .
وقد ذكر هذا الإسم سيد الشهداء عليه السلام في خطبته بمكة : «كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات ، بين النواويس وكربلاء إلخ»(٣٤٠) .
٩ ـ المقدفان :
ذكر هذا الاسم في الرواية التالية :
وقال الباقر عليه السلام : (خرج علي يسير بالناس ، حتى إذا كان بكربلاء على ميلين أو ميل ؛ تقدم بين أيديهم حتى طاف بمكان يقال له : المقدفان ، فقال : قتل فيها مائتا نبي ، ومائتا سبط كلهم شهداء ، ومناخ ركاب ومصارع عُشّاق شهداء ، لا يسبقهم من كان قبلهم ، ولا يلحقهم من بعدهم)(٣٤١) .
__________________
(٣٣٩) ـ المظفر ، الشيخ عبد الواحد : البطل العلقمي ، ج ٣ / ٢٥٨ ـ ٢٥٩.
(٣٤٠) ـ ابن طاووس ، علي بن موسى بن محمد : اللهوف في قتلى الطفوف / ٢٥.
(٣٤١) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار / ج ٤١ / ٢٩٥.
الفصل الثالث
أسماء طبيعية
١ ـ أرض غربة
٢ ـ أرض فَلَاة
٣ ـ بَطْحاء
٤ ـ التربة أو تربة
٥ ـ تربة بيضاء
٦ ـ تربة حمراء
٧ ـ تَلّ أعْفَر
٨ ـ شاطئ أو شط الفرات
٩ ـ الطين أو الطينة
١٠ ـ طين أحمر
١١ ـ طين القبر
١٢ ـ الطف أو الطفوف
١٣ ـ عَرْصَة
١٤ ـ الغَائِط
١ ـ أرض غربة :
ذكرت هذه التسمية في الحديث التالي :
عن عبد الله بن حماد البصري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (قال لي : إنّ عندكم ـ أو قال : في قربكم ـ لفضيلة ما أوتي أحد مثلها ، وما أحسبكم تعرفونها كُنه معرفتها ، ولا تحافظون عليها ولا على القيام بها ، وأنّ لها لأهلاً خاصة قد سمّوا لها ، وأعطوها بلا حول منهم ولا قوة ، إلا ما كان من صنع الله لهم ، وسعادة حباهم بها ، ورحمة ورأفة وتقدم. قلت جعلت فداك ، وما هذا الذي وصفت ولم تسمه؟ قال زيارة جدي الحسين عليه السلام ، فإنّه غريب بأرض غربة ، ويبكيه من زاره ، ويحزن من لم يزره ، ويحترق له من لم يشهده ...)(٣٤٢) .
٢ ـ أرض فَلَاة :
ذكرت هذه التسمية في الحديث التالي :
في حديث عبد الله بن حماد البصري المتقدم قال عليه السلام : (... ويرحمه من نظر إلى قبر ابنه عند رجليه في أرض فلاة ، ـ إلى أن قال ـ : قد أوحش قربه في الوحدة والبعد عن جده ، والمنزل الذي لا يأتيه إلا من امتحن الله قلبه للإيمان وعَرّفه حقنا)(٣٤٣) .
__________________
(٣٤٢) ـ النوري ، ميرزا حسين الطبرسي : مستدرك الوسائل ، ج ١٠ / ٢٥١ ـ ٢٥٢ (باب ٢٦ من أبواب المزار ـ حديث ٤٢).
(٣٤٣) ـ نفس المصدر / ٢٥٢.
٣ ـ بَطْحَاء :
ذكرت هذه التسمية في الحديث التالي :
عن المقبري ، عن عائشة قالت : (بينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راقداً ، إذ جاء الحسين يحبو إليه فنحيته عنه ، ثم قمت لبعض أمري فدنا منه فاستيقظ يبكي ، فقلت : ما يبكيك؟ قال : إنّ جبرئيل أراني التربة التي يقتل عليها الحسين ، فاشتد غضب الله على من يسفك دمه ، وبسط يده فإذا فيها قبضة من بطحاء ، فقال : يا عائشة ، والذي نفسي بيده إنّه ليحزنني ، فمن هذا من أمتي يقتل حسيناً بعدي)(٣٤٤) .
٤ ـ التربة أو تربة :
ورد هذا الاسم في عدة مرويات ، روتها العامة والخاصة ، نذكر منها ما يلي :
أ ـ مرويات السنة :
١ ـ عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنسائه : (لا تُبكوا هذا الصبي ؛ يعني حسيناً. قال : وكان يوم أم سلمة فنزل جبرئيل فدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الداخل ، وقال لأم سلمة : لا تدعي أحداً أن يدخل عليّ. فجاء الحسين فلما نظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البيت ، أراد أن يدخل فأخذته أم سلمة فاحتضنته وجعلت تناغيه وتسكنه ، فلما اشتد في البكاء خلّت عنه ، فدخل حتى جلس في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال جبرئيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : إنّ أمتك ستقتل ابنك هذا ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : يقتلونه وهم مؤمنون بي؟! قال : نعم يقتلونه.
__________________
(٣٤٤) ـ العسكري ، السيد مرتضى : معالم المدرستين ، ج ٣ / ٣٥.
فتناول جبريل تربة فقال : مكان كذا وكذا ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد إحتضن حسيناً كاسف البال مهموماً. فظنت أم سلمة أنّه غضب من دخول الصبي عليه فقالت : يا نبي الله جعلت لك الفداء ، إنّك قلت لنا : لا تُبكوا هذا الصبي ، وأمرتني أن لا أدع أحداً يدخل عليك ، فجاء فخلّيت عنه ، فلم يرد عليها ، فخرج إلى أصحابه وهم جلوس فقال : إنّ أمتي يقتلون هذا ، وفي القوم أبو بكر وعمر ، وفي آخر الحديث : فأراهم تربته)(٣٤٥) .
٢ ـ عن صالح بن أربد ، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله : إجلسي بالبالب ، ولا يَلِجَنّ عليّ أحد ، فقمت بالباب إذ جاء الحسين رضي الله عنه فذهبت أتناوله ، فسبقني الغلام فدخل على جده ، فقلت : يا نبي الله جعلني الله فداك ، أمرتني أن لا يلج عليك أحد ، وإنّ إبنك جاء فذهبت أتناوله فسبقني ، فلما طال ذلك فطلعت من الباب ، فوجدتك تقلب بكفيك شيئاً ، ودموعك تسيل ، والصبي على بطنك؟ قال : نعم ، أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أنّ أمتي يقتلونه ، وأتاني بالتربة التي يقتل عليها فهي التي أقلب بكفي)(٣٤٦) .
٣ ـ عن عثمان بن مقسم ، عن المقبري ، عن عائشة قالت : (بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راقد ، إذ جاء الحسين يحبوا إليه فنحيته عنه ، ثم قمت لبعض أمري ، فدنا منه فاستيقظ يبكي ، فقلت : ما يبكيك؟ قال : إنّ جبريل أراني التربة التي يقتل عليها الحسين ، فاشتد غضب الله على من يسفك دمه ، وبسط فإذا
__________________
(٣٤٥) ـ العسكري ، السيد مرتضى : معالم المدرستين ، ج ٣ / ٣٠ (عن مجمع الزوائد ٩ / ١٨٩ ـ وتاريخ ابن كثير ٨ / ١١٩).
(٣٤٦) ـ نفس المصدر / ٣١ (عن كنز العمال ١٦ / ٢٢٦).
فيها قبضة من بطحاء فقال : يا عائشة ، والذي نفسي بيده أنه ليحزنني ، فمن هذا من أمتي يقتل حسينا بعدي؟!)(٣٤٧) .
٤ ـ عن هاني ابن هاني ، عن علي قال : (ليقتل الحسين بن علي قتلاً ، وإني لأعرف تربة الأرض التي يقتل بها ، يقتل بقرية قريب من النهرين)(٣٤٨) .
٥ ـ عن أم سلمة قالت : (كان الحسن والحسين يلعبان بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيني ، فنزل جبرئيل فقال : يا محمد إنّ أمتك تقتل ابنك هذا من بعدك ، وأومأ بيده إلى الحسين ، فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضمه إلى صدره ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يا أم سلمة ، وديعة عندك هذه التربة. قالت : فشمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال : ريح كرب وبلاء. وقالت : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يا أم سلمة ، إذا تحولت هذه التربة دماً فاعلمي أنّ ابني قد قتل. قال : فجعلتها : أم سلمة في قارورة ، ثم جعلت تنظر إليها كي يوم تعني وتقول : إنّ يوماً تحولين دماً ليوم عظيم)(٣٤٩) .
٦ ـ عن أم سلمة : نعي إليّ الحسين وأتيت بتربته ، وأخبرت بقاتله ، أخبرني جبرئيل بأنّ ابني الحسين يقتل بأرض العراق ، فقلت لجبرئيل : أرني تربة الأرض التي يقتل بها فجاء فهذه تربتها)(٣٥٠) .
__________________
(٣٤٧) ـ المصدر السابق / ٣٥ (عن طبقات ابن سعد ـ ترجمة الحسين).
(٣٤٨) ـ المرعشي ، السيد شهاب الدين : ملحقات الإحقاق ، ج ١٧ / ٥٤٨ ـ ٥٤٩ ـ (عن الحافظ بن عساكر في تاريخ دمشق ـ ١٨٨ ، بيروت).
(٣٤٩) ـ نفس المصدر ، ج ١٩ / ٣٩٧ (عن ابن عساكر في تاريخ دمشق / ١٧٥).
(٣٥٠) ـ نفس المصدر ، ج ١١ / ٣٤٢ (عن المتقي الهندي في منتخب كنزل العمال ج ٥ / ١١١ ، المطبوع بهامش المسند ـ اليمنية مصر).
٧ ـ (من حديث أم سلمة ، زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت : كان عندي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعي الحسين ، فدنا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخذته فبكى فتركته ، فدنا منه فأخذته فبكى فتركته ، فقال له جبرئيل : أتحبه يا محمد؟ قال نعم. قال : إنّ أمتك ستقتله ، وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل بها ، فبسط جناحه فأراه منها فبكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم)(٣٥١) .
هذه بعض المرويات الواردة في كتب أهل السنة ، وبذلك نكتفي.
ب ـ مرويات الإمامية :
ورد هذا الإسم في عدة روايات نذكر منها التالي :
١ ـ عن الحجال ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (التربة من قبر الحسين بن علي (عليه السلام) عشرة أميال)(٣٥٢) .
٢ ـ عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر بن محمد عليه السلام يقولان : (إنّ الله عَوّض الحسين عليه السلام من قتله ، أن الإمامة من ذريته ، والشفاء في تربته ، وإجابة الدعاء عند قبره ، ولا تعد أيام زائريه جائياً وراجعاً من عمره)(٣٥٣) .
٣ ـ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (إنّ جبريل أتى رسول الله ، والحسين يلعب بين يدي رسول الله قال : فخسف ما بين مجلس رسول الله إلى المكان الذي قتل فيه ، حتى إلتفت القطعتان فأخذ منها ، ودحيت في
__________________
(٣٥١) ـ المصدر ال سابق ، ج ١١ / ٣٤٣ (عن ابن عبد ربه في العقد الفريد ج ٢ / ٢١٩ ، الشرقية. مصر).
(٣٥٢) ـ الطوسي ، الشيخ محمد حسن : تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ٧٢.
(٣٥٣) ـ الحر العاملي ، الشيخ محمد بن الحسن : وسائل الشيعة ، ج ١٠ / ٣٢٩ ـ ٣٣٠ (باب ٢٧ من ٍأبواب المزار ـ حديث ٣٤).
أسرع من طرفة العين ، فخرج وهو يقول : طوبى لك من تربة ، وطوبى لمن يقتل حولك ...)(٣٥٤) .
٤ ـ عن ابن عباس قال : (الملك الذي جاء إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم يخبره بقتل الحسين ، كان جبرئيل الرُّوح الأمين ، منشور الأجنحة ، باكياً صارخاً ، قد حمل من تربته ، وهو يفوح كالمسك ، فقال رسول الله : وتفلح أمتي تقتل فرخي ، أو قال : فرخ ابنتي؟ فقال جبرئيل : يضربها الله بالإختلاف فيختلف قلوبهم)(٣٥٥) .
٥ ـ عن عبد الملك بن أعين قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : (إنّ رسول الله كان في بيت أم سلمة وعنده جبرئيل ، فدخل عليه الحسين فقال له جبرئيل : إنّ أمتك تقتل إبنك هذا ، ألا أريك تربة الأرض التي يقتل فيها؟ فقال رسول الله : نعم. فأهوى جبرئيل بيده وقبض قبضة منها فأراها النبي صلى الله عليه وآله وسلم)(٣٥٦) .
٦ ـ عن المعلى بن خنيس ، قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبح فرأته فاطمة باكياً حزيناً ، فقالت : مالك يا رسول الله؟ فأبى أن يخبرها ، فقالت : لا آكل ولا أشرب حتى تخبرني ، فقال : إنّ جبرئيل عليه السلام أتاني بالتربة التي يقتل عليها غلام لم يحمل به بعد ـ ولم تكن تحمل بالحسين عليه السلام ـ وهذه تربته)(٣٥٧) .
__________________
(٣٥٤) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٤٤ / ٢٣٥.
(٣٥٥) ـ نفس المصدر / ٣٣٧.
(٣٥٦) ـ نفس المصدر / ٢٣٩.
(٣٥٧) ـ بن قولويه ، الشيخ جعفر بن محمد : كامل الزيارات / ١٣٢ (الباب ١٧ ـ الحديث ٩).
٧ ـ عن عبد الرحمان الغنوي ، عن سليمان قال : (وهل بقي في السماوات ملك لم ينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعزيه بولده الحسين عليه السلام ، ويخبره بثواب الله إياه ، ويحمل إليه تربته مصروعاً عليها ، مذبوحاً مقتولاً ، جريحاً مخذولاً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : اللهم اخذل من خذله ، واقتل من قتله ، واذبح من ذبحه ، ولا تمتعه بما طلب. قال عبد الرحمان : فوالله لقد عوجل الملعون يزيد ، ولم يتمتع بعد قتله بما طلب. قال عبد الرحمان : ولقد أُخذ مغافصة ، بات سكراناً وأصبح ميتاً متغيراً ، كأنّه مطليّ بقار أخذ على أسف ، وما بقي أحد ممن تابعه على قتله ، أو كان في محاربته إلا أصابه جنون أو جذام أو برص ، وصار ذلك وراثة في نسلهم)(٣٥٨) .
٥ ـ تربة بيضاء :
عن عائشة قالت : (دخل الحسين بن علي عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوحى إليه ، فبرك على ظهره وهو منكبّ ولعب على ظهره ، فقال جبرئيل : يا محمد ، إنّ أمتك ستفتن بعدك وتقتل ابنك هذا من بعدك ، ومدّ يده فأتاه بتربة بيضاء وقال : في هذه الأرض يقتل ابنك ـ إسمها الطف ـ فلمّا ذهب جبرئيل ؛ خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه والتربة في يده ، وفيهم أبو بكر ، وعمر ، وعلي ، وحذيفة ، وعمار ، وأبو ذر ، وهو يبكي ، فقالوا : ما يبكيك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال : أخبرني جبرئيل أنّ ابني الحسين يقتل بعدي بأرض الطف ، وجاءني بهذه التربة فأخبرني أنّ فيها مضجعه)(٣٥٩) .
__________________
(٣٥٨) ـ بن قولويه ، الشيخ جعفر بن محمد : كامل الزيارات / ١٣١ ـ ١٣٢ (الباب ١٧ ـ الحديث ٨).
(٣٥٩) ـ الشهرستاني ، السيد صالح بن السيد إبراهيم : تاريخ النياحة / ٢٣ ـ ٢٤.
والمرعشي ، السيد شهاب الدين : ملحقات الإحقاق ، ج ١١ / ٢٨٦ ، (عن الطبراني في المعجم الكبير / ١٤٤ ـ مخطوط).
٦ ـ تربة حمراء :
ورد هذا الاسم في عدة روايات ، ذكرتها المصادر الشيعية والسنية كالتالي :
أ ـ مرويات السنة :
١ ـ عن عبد الله بن وهب بن زمعة قال : أخبرتني أم سلمة (رض) : (إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إضطجع ذات ليلة للنوم فاستيقظ وهو حائر ، ثم إضطجع فرقد ثم استيقظ وهو حائر دون ما رأيت به المرة الأولى ، ثم إضطجع فاستيقظ وفي يده تربة حمراء يقبلها ، فقلت : ما هذه التربة يا رسول الله؟ قال : ـ أخبرني جبريل عليه الصلاة والسلام : أنّ هذا يقتل بأرض العراق ـ للحسين ـ فقلت لجبريل : أرني تربة الأرض التي يقتل بها ، فهذه تربتها)(٣٦٠) .
٢ ـ وأخرج البيهقي ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : (أن الحسين دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده جبرئيل في مشربة عائشة ، فقال له جبرئيل : ستقتله أمتك ، وإن شئت أخبرتك بالأرض التي يقتل فيها ، وأشار جبرئيل بيده إلى الطف بالعراق فأخذ تربة حمراء فأراه إياها)(٣٦١) .
٣ ـ عن عائشة : (إنّ جبرئيل أتاني فيخبر : أنّ إبني هذا تقتله أمتي ، قلت : فأراني تربته فأتاني بتربة حمراء)(٣٦٢) .
__________________
(٣٦٠) ـ المرعشي ، السيد شهاب الدين : ملحقات الإحقاق ، ج ١١ / ٣٢٩ ، (عن الحاكم النيسابوري في المستدرك ، ج ٤ / ٣٩٨ ـ حيدر آباد).
(٣٦١) ـ نفس المصدر ، ج ١١ / ٣٤٤ (عن السيوطي في الخصايص الكبرى ، ج ٢ / ١٢٥ ـ حيدر آباد).
(٣٦٢) ـ نفس المصدر ، ج ١١ / ٣٨٧ ، (عن المتقي الهندي في منتخب كنز العمال ، ج ٥ / ١١٠ مطبوع بهامش المسند ـ مصر).
٤ ـ عن عبد الله بن سعيد ، عن أبيه ، عن عائشة : (أنّ الحسين بن علي دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : يا عائشة ألا أجبك ، لقد دخل عليَّ ملك آنفاً ما دخل عليّ قط فقال : إنّ ابني هذا مقتول ، وقال : إن شئت أريك تربة يقتل فيها ، فتناول الملك بيده فأراني تربة حمراء)(٣٦٣) .
٥ ـ عن ابن عباس قال : (كان الحسين (عليه السلام) جالساً في حجر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فقال جبريل : أتحبه؟ فقال : وكيف لا أحبه وهو ثمرة فؤادي؟ فقال : إنّ أمتك ستقتله ؛ ألا أريك من موضع قبره فقبض قبضة فإذا تربة حمراء)(٣٦٤) .
٦ ـ وأخرج ابن سعد إنّه صلى الله عليه وآله وسلم ، كان له مشربة درجتها في حجرة عائشة ، يرقى إليها إذا أراد لقاء جبرئيل ، فرقي إليها وأمر عائشة أن لا يطلع إليه أحد ، فرقي حسين ـ عليه السلام ـ ولم تعلم به ، فقال جبريل ـ عليه السلام ـ من هذا؟ قال : ابني فأخذه رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ فجعله على فخذه ، فقال جبريل : ستقتله أمتك ، فقال ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ابني؟ قال : نعم ، وإن شئت أخبرتك الأرض التي يقتل فيها ، فأشار جبريل بيده إلى الطف بالعراق ، فأخذ منها تربة حمراء فأراه إياها ، وقال : هذه من تربة مصرعه)(٣٦٥) .
__________________
(٣٦٣) ـ حنبل ، أحمد بن محمد : مسند الإمام أحمد ، ج ٦ / ٢٩٤.
(٣٦٤) ـ الهيثمي ، الحافظ علي بن أبي بكر : مجمع الزوائد ، ج ٩ / ١٩١.
(٣٦٥) ـ ابن حجر ، شهاب الدين أحمد : الصواعق المحرقة : ١١٥.
ب ـ مرويات الإمامية :
١ ـ عن يونس بن رفيع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (إنّ عند رأس الحسين بن علي عليه السلام لتربة حمراء ، فيها شفاء من كل داء إلا السام ، قال : فأتيت القبر بعد ما سمعنا بهذا الحديث ، فاحتفرنا عند رأس القبر ، فلما حفرنا قدر ذراع ؛ إنحدرت علينا من عند رأس القبر مثل السهلة حمراء قدر درهم ، فحملناه إلى الكوفة فمزجناه ، وأقبلنا نعطي الناس يتداوون)(٣٦٦) .
٢ ـ عن أنس بن مالك : (إنّ عظيماً من عظماء الملائكة إستأذن ربّه عَزّ وجَلّ في زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأذن له ، فبينما هو عنده ، إذ دخل عليه الحسين عليه السلام فقبّله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأجلسه في حجره ، فقال له : الملك : أتحبه؟ قال : أجل أشد الحب إنه إبني ، قال له : إنّ أمتك ستقتله ، قال : أُمتي تقتل ولدي (ابني هذا)؟ قال : نعم ، وإن شئت أريتك من التربة التي يقتل عليها ، قال : نعم ، فأراه تربة حمراء طيبة الريح ، فقال : إذا صارت هذه التربة دماً عبيطاً فهو علامة قتل ابنك هذا)(٣٦٧) .
٣ ـ عن أم الفضل بنت الحارث : (أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : يا رسول الله ، رأيت حلماً منكراً قال : وما هو؟ قالت : إنّه شديد ، قال : وما هو؟ قالت رأيت كأنّ قطعة من جسدك قد قطعت ووضعت في حجري ، فقال رسول الله : خيراً رأيتِ تلد فاطمة غلاماً فيكون في حجرك. فولدت فاطمة الحسين عليه السلام ، قالت : وكان في حجري كما قال رسول الله ، فدخلت به يوماً على النبي فوضعته في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم حانت مني إلتفاتة
__________________
(٣٦٦) ـ بن قولويه ، الشيخ جعفر بن محمد : كامل الزيارات / ٤٦٨ (اباب ٩٣ ـ الحديث ١).
(٣٦٧) ـ البحراني ، الشيخ محمد بن نور : العوالم ، ج ٧ / ١٢٥.
فإذا عينا رسول الله تهرقان بالدموع ، فقلت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله مالك؟ قال : أتاني جبرئيل فأخبرني أنّ أمتي ستقتل ابني هذا ، وأتاني بتربة حمراء من تربته)(٣٦٨) .
٤ ـ عن أبي أسامة زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (نعى جبرئيل عليه السلام الحسين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت أم سلمة ، فدخل عليه الحسين وجبرئيل عنده فقال : إنّ هذا تقتله أمتك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أرني من التربة التي يسفك فيها دمه ، فتناول جبرئيل عليه السلام قبضة من تلك التربة ، فإذا هي تربة حمراء)(٣٦٩) .
٧ ـ تَلّ أعْفَر :
ذكر هذا الإسم في الحديث التالي :
عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (قال عبد الله بن الزبير للحسين بن علي عليه السلام : لو جئت إلى مكة فكنت بالحرم؟ فقال الحسين بن علي عليه السلام : لا نستحلها ولا تستحلّ بنا ، ولأن أقتل على تلّ أعفر أحبّ إلي من أن أقتل بها)(٣٧٠) .
إيضاح وبيان :
يستفاد من هذا الحديث أنّ سيد الشهداء عليه السلام أشار بـ(تل أعفر) إلى طبيعة الأرض التي يقتل عليها ، ويمكن إيضاح هذا المعنى بما يلي :
__________________
(٣٦٨) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٤٤ / ٢٣٨ ـ ٢٣٩.
(٣٦٩) ـ بن قولويه ، الشيخ جعفر بن محمد : كامل الزيارات / ١٢٨ ـ ١٢٩ ، (باب ١٧ ـ حديث ٢).
(٣٧٠) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٤٥ / ٨٦.
أولاً ـ معنى (تَلْ) :
«التي من التراب معروف ، هو الرابية والجمع تلال»(٣٧١) ولما كانت أرض كربلاء غير مستوية ، بل تكثر فيها التلال والمرتفعات عَبّر عنها الإمام عليه السلام بـ(تل) ويؤيد هذا ما يلي :
ذكر الدكتور السيد سلمان آل طعمة : «نينوى وتقع شرقي كربلاء ، وهي سلسلة تلول أثرية تمتد من جنوب سدة الهندية ، حتى مصب نهر العلقمي في الأهوار ، وتعرف بتلول نينوى»(٣٧٢) .
وذكر العلامة الكبير السيد هبة الدين الشهرستاني (قده) : «وكان لهذا الحائر وهدة فسيحة محدودة بسلسلة تلال ممدودة ، وربوات تبدأ من الشمال الشرقي ، متصلة بموقع باب السدرة في الشمال ، وهكذا إلى موضع الباب الزينبي من جهة الغرب ، ثم تنزل إلى موضع الباب القبلي في جهة الجنوب ، وكانت هذه التلال المتقاربة تشكل للناظرين نصف دائرة مدخلها الجهة الشرقية ، حيث يتوجه منها الزائر إلى مثوى سيدنا العباس بن علي ـ عليهما السلام ـ ويجد المنقبون في أعماق البيوت المحدقة بقبر الحسين عليه السلام ، آثار إرتفاعها القديم في أراضي جهات الشمال والغرب ، ولا يجدون في الجهة الشرقية سوى تربة رخوة واطئة ، الأمر الذي يرشدنا إلى وضعيّة هذه البقعة ، وأنها كانت في عصرها القديم واطئة من جهة الشرق ، ورابية من جهتي الشمال والغرب على شكل
__________________
(٣٧١) ـ الطريحي ، الشيخ فخر الدين : مجمع البحرين ، ج ٥ / ٣٢٨.
(٣٧٢) ـ آلأ طعمة ، السيد سلمان هادي : تاريخ مرقد الحسين والعباس : ٢٢.
هلالي ، وفي هذه الدائرة الهلالية ، حُوصِرَ ابن الزهراء عليها السلام في حربه حين قتل»(٣٧٣) . فعبّر عليه السلام عن هذه التلال المتقاربة بـ(تل).
ويؤيد هذا المعنى ما جاء في رواية يحيى بن عبد الرحمان ، بن أبي لبينة ، عن جده محمد بن عبد الرحمان قال : (بينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت عائشة (رضي الله عنها) رَقْدَة القائلة ، إذ استيقظ وهو يبكي ، فقالت عائشة : ما يبكيك يا رسول الله ، بأبي أنت وأمي؟ قال يبكيني أن جبرئيل أتاني فقال : أبسط يدك يا محمد ، فإنّ هذه تربة من تلال يقتل بها إبنك الحسين ، يقتله رجل من أمتك. قالت عائشة : ورسوله يحدثني وأنّه ليبكي ويقول : من ذا من أمتي ، من ذا من أمتي ، من ذا من أمتي؟! من يقتل حسيناً من بعدي؟!)(٣٧٤)
ثانياً ـ معنى (الأعفر) :
«الرمل الأحمر ، والأعفر الأبيض وليس بالشديد الأبيض وكثيب أعفر : ذو لونين : الحمرة والبياض ، وهذا ما ذكرته الروايات من أنّ لون التربة حمراء وبيضاء ؛ أي أنّ سيد الشهداء عليه السلام أشار إلى لون ذلك التل ، وهذه التسمية ذكرها الحموي حيث قال : «تل أعفر : بالفاء ؛ هكذا تقول عامة الناس ، وأما خواصهم فيقولون (تل يعفر). وقيل : إنما أصله التل الأعفر للونه فُغيّر بكثرة الإستعمال وطلب الخفة»(٣٧٦) .
__________________
(٣٧٣) ـ الشهرستاني ، السيد هبة الدين : نهضة الحسين / ٩٠.
(٣٧٤) ـ الأربلي ، الشيخ علي بن عيسى : كشف الغمة ، ج ٢ / ٢٦٩.
(٣٧٥) ـ الطريحي ، الشيخ فخر الدين : مجمع البحرين ، ج ٣ / ٤٠٩.
(٣٧٦) ـ الحموي ، شهاب الدين ياقوت : معجم البلدان ، ج ٢ / ٣٩.
ثالثاً ـ تلّعْفَر :
«بلدة في العراق مركز قضاء تَلّعْفَر (محافظة نينوى) بقايا قلعة عرين»(٣٧٧) .
وهذا الإحتمال بعيد لا يعتد به ؛ لما ذكرناه سابقاً.
٨ ـ شاطئ أو شط الفرات :
«الشط : جانب النهر الذي ينتهي إليه حد الماء ، والجمع شطوط كفلس وفلوس. والشط جانب الوادي وشاطئ الوادي : جانبه»(٣٧٨) .
وتسمى كربلاء بشط الفرات أو شاطئ الفرات ؛ لأنّها واقعة على طرف البرية من جهة ، وعلى جانب الفرات من جهة أخرى ، وهو الفرات التي يمر بها ، وكثيراً ما ورد ذلك في الروايات بهذين الإسمين كالتالي :
أ ـ مرويات السنة :
عن عبد الله بن نجا ، عن أبيه : (أنّه سار مع علي ـ وكان صاحب مطهرته ـ فلما حاذى نينوى وهو مطلق إلى صفين فنادى علي : اصبر أبا عبد الله ، اصبر ابا عبد الله بشط الفرات. قلت وماذا؟ قال دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم وعيناه تفيضان ، قلت : يا نبي الله أغضبك أحد ، ما شأن عينك تفيضان؟ قال : بلى قام من عندي جبرئيل قبل فحدثني أنّ الحسين يقتل بشط الفرات. قال : فقال : هل لك أن أشمك من تربته؟ قال : قلت : نعم. فمد يده فقبض قبضه من تراب فأعطانيها ، فلم أملك عيني أن فاضتا)(٣٧٩) .
__________________
(٣٧٧) ـ اليسوعي ، الأب فردينانا توتل : المنجد في الأعلام / ١٩١.
(٣٧٨) ـ الطريحي ، الشيخ فخر الدين بن الشيخ محمد علي : مجمع البحرين ، ج ٤ / ٢٥٨.
(٣٧٩) ـ بن حنبل ، أحمد بن محمد : مسند الإمام أحمد ، ج ١ / ٨٥.
ب ـ مرويات الإمامية :
ا ـ عن الخيبري ، عن الحسين بن محمد قال : قال أبو ال حسن موسى عليه السلام : (أدنى ما يثاب به زائر أبي عبد الله عليه السلام بشط الفرا ت، إذا عرف حقه وحرمته وولايته ، أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)(٣٨٠) .
٢ ـ عن الحسين بن محمد القمي ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : (من زار قبر أبي عبد الله الحسين بشط الفرات ، كان كمن زار الله فوق عرشه)(٣٨١) .
٣ ـ عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : (إنّ الحسين عليه السلام خرج من مكة قبل التروية بيوم فشيّعه عبد الله بن الزبير فقال : يا أبا عبد الله لقد حضر الحج وتدعه وتأتي العراق! فقال : يا ابن الزبير لأدفن بشاطئ الفرات ، أحب إليّ من أن أدفن بفناء الكعبة)(٣٨٢) .
٤ ـ وروى أبو مخنف في مقتله : بإسناده عن الكلبي أنه قال : «وساروا جميعاً إلى أن أتوا أرض كربلاء ـ وذلك يوم الأربعاء ـ فوقف فرس الحسين عليه السلام من تحته فنزل عنا وركب أخرى ، فلم ينبعث من تحته خطوة واحدة يميناً وشمالاً ، ولم يزل يركب فرساً بعد فرس حتى ركب سبعة أفراس ، وهن على هذا الحال ، فلما رأى الإمام صلوات الله عليه ذلك الأمر الغريب قال : يا قوم ما يقال لهذه الأرض؟ قالوا أرض الغاضرية. قال فهل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى نينوى. قال هل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى بشاطئ الفرات. قال هل لها اسم غير هذا؟ قالوا : تسمى كربلاء. قال : فعند
__________________
(٣٨٠) ـ الحر العاملي ، الشيخ محمد بن الحسن : وسائل الشيعة ، ج ١٠ / ٣١٩ ، (باب ٣٧ من أبواب المزار ـ حديث ٤).
(٣٨١) ـ نفس المصدر ، ج ١٠ / ٣١٩ ، (باب ٣٧ من أبواب المزار ـ حديث ٥).
(٣٨٢) ـ بن قولويه ، الشيخ جعفر بن محمد : كامل الزيارات / ١٥١ ـ ١٥٢ ، (باب ٢٣ ـ حديث ٩).
ذلك تنفس الصُعَدَاء ، وقال : أرض كرب وبلاء. ثم قال : قفوا ولا ترحلوا فههنا والله مناخ ركابنا ، وههنا والله سفك دمائنا ، وههنا والله هتك حريمنا ، وههنا والله قتل رجالنا ، ههنا ذبح أطفالنا ، وههنا والله تزار قبورنا ، وبهذا التربة وعدني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، لا خلف لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم أنه عليه السلام نزل عن فرسه»(٣٨٣) .
٩ ـ الطين أو الطينة :
ذكر هذا الإسم في الأحاديث التالية :
١ ـ عن إمامنا الصادق عليه السلام : (وقل إذا أخذته : اللهم إني أسألك بحقّ هذه الطينة ، وبحق الملك الذي أخذها ، وبحق النبي الذي قبضها ، وبحق الوصي الذي حَلّ فيها ، صلِّ على محمد وأهل بيته ، واجعل لي فيها شفاء من كل داء ، وأماناً من كل خوف)(٣٨٤) .
٢ ـ عن أبي جعفر الموصلي ، إنّ جعفر عليه السلام قال : (إذا أخذت طين قبر الحسين عليه السلام ؛ فقل : اللهم بحق هذه التربة ، وبحق الملك المُوكّل بها ، وبحق الملك الذي كَرَبَها ، وبحق الوصي الذي هو فيها ، صَلِّ على محمد وآل محمد ، واجعل هذا الطين شفاء لي من كُلِّ داءٍ ، وأماناً من كل خوف)(٣٨٥) .
٣ ـ عن أبي حمزة الثمالي ، قال : قال الصادق عليه السلام : (... واجعل هذا الطين شِفَاءً لي ولمن يستشفني به من كُلِّ داءٍ وسُقْمٍ ومرض ، وأماناً من كُلِّ خوف)(٣٨٦) .
__________________
(٣٨٣) ـ البهبهاني ، الشيخ محمد باقر : الدمعة الساكبة ، ج ٤ / ٢٥٦.
(٣٨٤) ـ بن قولويه ، الشيخ جعفر بن محمد : كامل الزيارات / ١٢٨ ـ ١٢٩ ، (باب ١٧ ـ حديث ٤).
(٣٨٥) ـ نفس المصدر / ٤٦٩ ـ ٤٧٠ ، (باب ٩٣ ـ حديث ٤).
(٣٨٦) ـ نفس المصدر / ٤٧٥ ، (باب ٩٣ ـ حديث ١٢).
٤ ـ عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (لو كان أنّ مريضاً من المؤمنين يعرق حَقَّ أبي عبد الله وحرمته وولايته ، أخذ له من طينته على راس ميل ؛ كان له دواء وشفاء)(٣٨٧) .
١٠ ـ طين أحمر :
ورد هذا الاسم في الحديث التالي :
عن أب يبكر قال : (أخذت من التربة التي عند رأس الحسين بن علي عليه السلام طيناً أحمر ، فدخلت على الرضا عليه السلام فعرضتها عليه فأخذها في كَفّه ، ثم شَمّها ثم بكى حتى جرت دموعه ، ثم قال : هذه تربة جدي)(٣٨٨) .
١١ ـ طين القبر :
ورد هذا الاسم في بعض الروايات ، نذكر منها ما يلي :
عن أبي اليسع قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام ـ وأنا أسمع ـ قال : (آخذ من طين القبر يكون عندي أطلب بركته؟ قال : لا بأس بذلك)(٣٨٩) .
١٢ ـ الطف أو الطفوف :
قال ياقوت الحموي : «الطّفُّ : بالفتح ، والفاء مشددة ؛ وهو في اللغة ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق ، قال الأصمعي : وإنما سُمِّي طَفّاً لأنّه دانٍ من الريف من قولهم : خُذ ما طفّ ، أي ما دنا وأمكن. وقال أبو سعيد : سمي الطف ؛ لأنّه مشرف على العراق من أطفّ على الشيء بمعنى أطل ، والطف طف الفرات أي الشاطئ والطف : أرض من ضاحية الكوفة في
__________________
(٣٨٧) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٩٨ / ١٢٥.
(٣٨٨) ـ نفس المصدر : ١٣١.
(٣٨٩) ـ النوري ، ميرزا حسين الطبرسي : مستدرك الوسائل ، ج ١٠ / ٣٣١ ، (باب ٥٣ من أبواب المزار ـ حديث ٥).
طريق البرية ، فيه كان مقتل الحسين ابن علي ، رضي الله عنه ، وهي أرض بادية قريبة من ريف فيها عدة عيون ماء جارية ، منها الصيد والقُطْقُطانة ، والرُّهَيمة ، وعين جمل ، وهي عيون كانت للموكلين بالمسالح التي وراء خندق سابور ، أقطعهم أرضها يعتملونها من غير أن يلزمهم خراجاً»(٣٩٠) .
وقد ورد ذكر الطف في الأحاديث النبوية الشريف ، قبل إستشهاد الإمام الحسين عليه السلام وهي كالتالي :
أ ـ مرويات السنة :
١ ـ وأخرج البيهقي ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (أنّ الحسين دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده جبريل في مشربة عائشة ، فقال له جبريل : ستقتله أمّتك ، وإن شئت أخبرتك بالأرض التي يقتل فيها ، وأشار جبريل بيده إلى الطّف بالعراق فأخذ تربة حمراء فأراه إياها)(٣٩١) .
٢ ـ حدثنا أحمد بن رشد الحصري ، حدثنا عمرو بن خالد الحرّاني ، حدثنا ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة (رض) قالت : (دخل الحسين بن علي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو يوحى إليه فنرى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو منكب ، ولعب على ظهره ، فقال جبرئيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أتحبه يا محمد؟ قال : يا جبرئيل ومالي لا أحب ابني ، قال : فإنّ أمتك ستقتله من بعدك ، فمدّ جبرئيل عليه السلام يده فأتاه بتربة بيضاء فقال : في هذه الأرض يقتل ابنك هذا يا محمد واسمها الطف ،
__________________
(٣٩٠) ـ الحموي ، شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت : معجم البلدان ، ج ٤ / ٣٥ ـ ٣٦.
(٣٩١) ـ المرعشي ، السيد شهاب الدين : ملحقات الإحقاق ، ج ١١ / ٣٤٤ ، (عن الخصايص الكبرى ، ج ٢ / ١٢٥ ، ط ـ حيدر آباد).
فلما ذهب جبرئيل عليه السلام أخبرني : أنّ الحسين إبني مقتول في أرض الطف ، وأنّ أمتي ستفتن بعدي ، ثم خرج إلى أصحابه ـ فيهم علي وأبو بكر وعمر وحذيفة وعَمّار وأبو ذر (رض) ـ وهو يبكي ، فقالوا : ما يبكيك ي ارسول الله؟ فقال : أخبرني جبرئيل : أنّ ابني الحسين يقتل بعدي بأرض الطف ، وجائني بهذه التربة ، وأخبرني أنّ فيها مضجعه)(٣٩٢) .
٣ ـ روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم : (كان له مشربة درجتها في حجرة عائشة ، يرقى إليه إذا أراد لقى جبرئيل ، فرقى إليها وأمر عائشة أنّ لا يطلع إليها أحد ، فرقى حسين ولم تعلم به ، فقال جبريل : من هذا؟ قال : إبني فأخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعله على فخذه ، فقال جبريل : ستقتله أمتك ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : إبني؟ قال : نعم وإن شئت أخبرتك الأرض التي يقتل فيها ، فأشار جبريل بيده إلى الطف بالعراق ، فأخذ منها تربة حمراء فأراه إياها ، وقال : هذه من تربة مصرعه)(٣٩٣) . وبهذا القدر من الروايات نكتفي.
ب ـ مرويات الإمامية :
١ ـ عن أبي سعيد عقيصا قال : (سمعت الحسين بن علي عليهما السلام وخلابه عبد الله بن الزبير ، وناجاه طويلاً ، قال : ثم أقبل الحسين عليه السلام بوجهه إليهم وقال : إنّ هذا يقول لي : كن حماماً من حمام الحرم ، لأن أقتل وبيني وبين الحرم باع أحب إلى من أن أقتل وبيني وبينه شبر ، لأن أقتل بالطف أحب إلي من أن أقتل بالحرم)(٣٩٤) .
__________________
(٣٩٢) ـ المصدر السابق / ٣٨٦ ، (عن المعجم الكبير / ١٤٤ ـ مخطوط).
(٣٩٣) ـ ابن حجر ، شهاب الدين أحمد : الصواعق المحرقة : ١٩٣.
(٣٩٤) ـ ابن قولويه ، الشيخ جعفر بن محمد : كامل الزيارات / ١٥٠ ـ ١٥١ (الباب ٢٣ ـ الحديث ٧).
٢ ـ في حديث زائدة عن الإمام زين العابدين عليه السلام قال : (فكادت نفسي تخرج ، وتبينت ذلك عمتي زينب بنت علي الكبرى فقالت : مالي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وأخوتي؟ فقلت : وكيف لا أجزع وأخلع ، وقد أرى سيدي وأخوتي وعمومتي وولد عمي وأهلي مضرجين بدمائهم مرملين بالعراء مسلبين ، ولا يكفنون ولا يوارون ، ولا يعرج عليهم أحد ولا يقربهم بشر ، وكأنهم أهل بيت من الديلم والخزر ، فقالت : لا يجز عنك ما ترى فوالله إنّ ذلك لعهد من رسول الله إلى جدك وأبيك وعمك ، ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة ، لا يعرفهم فراعنة هذه الأرض ، وهم معروفون في أهل السماوات ، وأنّهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرقة فيوارونها ، وهذه الجسوم المضرجة ، وينصبون لهذا الطف علماً لقبر الشهداء ، لا يدرس أثره ، ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأيام ، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه ، فلا يزداد أثره إلا ظهوراً وأمره إلا علوا)(٣٩٥) .
١٣ ـ عَرْصَة :
قال ابن الأثير : «العرصات : جمع عرصة ؛ وهي كل موضع واسع لا بناء فيه»(٣٩٦) .
وقد ذكر هذا الإسم في بعض الروايات كالتالي :
١ ـ عن الأصبغ بن نباته قال : (أتينا مع علي فمررنا بموضع قبر الحسين ، فقال علي : هاهنا مناخ ركابهم ، وهاهنا موضع رحالهم ، وهاهنا مهراق
__________________
(٣٩٥) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٤٥ / ١٧٩ ـ ١٨٠.
(٣٩٦) ـ ابن الأثير ، المبارك بن محمد الجزري : والنهاية في غريب الحديث والأثر ، ج ٣ / ٢٠٨.
دمائهم ، فتية من آل محمد يقتلون بهذه العرصة ، وتبكي عليهم السماء والأرض)(٣٩٧) .
٢ ـ عن جابر الجعفي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (من بات عند قبر الحسين عليه السلام ليلة عاشوراء ؛ لقى الله يوم القيامة ملطخاً بدمه ، كأنما قتل معه في عرصة كربلاء)(٣٩٨) .
١٤ ـ الغَائِط :
قال ابن منظور : «الغوط والغائط : المتسع من الأرض مع طمأنينة ، وجمعه أغواط وغوطه ـ وغياط وغيطان»(٣٩٩) .
ونَصّ على هذا الإسم الحديث التالي :
عن أبي عبد الله الضبي قال : «دخلنا على هرثمة الضبي حين أقبل من صفين ـ وهو مع علي ـ وهو جالس على دكان له ، وله إمرأة يقال لها جرداء ؛ وهي أشد حباً لعلي وأشد لقوله تصديقاً ، فجاءت شاة له فبعرت فقال لها : لقد ذكرني بعر هذه الشاة حديثاً لعلي ، قالوا : وما عِلمٌ بهذا؟ قال : أقبلنا مرجعنا من صفين فنزلنا كربلاء فصلى بنا علي صلاة الفجر بين شجيرات ودوحات حرمل ، ثم أخذ كفاً من بعر الغزلان فشمّه ، ثم قال : أوه ، أوه ، يقتل بهذا الغائط قوم يدخلون الجنة بغير حساب» ، قال : قالت جرداء : وما تنكر من هذا؟ هو أعلم بما قال منك ، نادت بذلك وهي في جوف البيت)(٤٠٠) .
__________________
(٣٩٧) ـ العسكري ، السيد مرتضى : معالم المدرسين ، ج ٣ / ٣٨.
(٣٩٨) ـ الحر العاملي ، الشيخ محمد بن الحسن : وسائل الشيعة ، ج ٤ / ٤٧٧ (باب ٥٥ من أبواب المزار ـ حديث ٣).
(٣٩٩) ـ ابن منظور ، محمد بن مكرم : لسان العرب ، ج ٧ / ٣٦٤.
(٤٠٠) ـ العسكري ، السيد مرتضى : معالم المدرستين ، ج ٣ / ٤١.
البحث الثاني
نتائج البحث
١ ـ إهتمام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بالتربة الحسينية
٢ ـ إهتمام الملائكة بالحسين عليه السلام وتربته
٣ ـ إهتمام الأنبياء بالحسين عليه السلام وتربته
٤ ـ تقديس التربة والتبرك بها
٥ ـ خصايص التربة الحسينية
٦ ـ المجاورة في كربلاء والأماكن المقدسة
بعد عرض الأسماء التي ذكرتها الروايات المتقدمة في الفصل السابق ؛ نخرج بالنتيجة التالية :
١ ـ إهتمام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بالتربة الحسينية :
س / من أمعن النظر في الروايات المتقدمة ؛ علم أنّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تكرر منه الإخبار بمصرع سبطه سيد الشهداء عليه السلام ، والإتيان بتربة مصرعه في بيوت زوجاته ، وعلى ملأ من أصحابه ، فما هو الهدف من ذلك؟
ج / قال الشيخ الدربندي (قده) :
«لعلّ السّر في تعدد ذلك وتكرره ، هو أنّه كان في كل واحد واحد من تلك الأوقات والأزمنة ، تجديد العهد ، وتأكيد الميثاق من الله عَزّ وجَلّ ، بالنسبة إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وآله المعصومين ، من الصبر الأوفى والتفويض الأكمل والتوكيل الأتم ، والأخذ بأزمّة المشيئة ، والرضا بما يشاء الله تعالى ويرضى به ، حيث يدعو الله تعالى في وقت من تلك الأوقات ، لأنْ يرد هذا البلاء عنهم ، ويدفع عنهم ذلك القضاء ، فإنّه يمحو ما يشاء ، ويثبت وعنده أم الكتاب»(٤٠١) .
وقال الشيخ الأميني (قده) ـ وخلاصة مقاله ما يلي :
«فإن من المتسالم عليه لدى الأمة المسلمة ، نظراً إلى النبوة الخاتمة وشؤونها الخاصة ، الإذعان بعلم النبي الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم بالملاحم والفتن ، وما جرى على أهل بيته وعترته وذي قرباه وذويه ، قُلّه وكثره من المصائب الهائلة ، وطوارق الدهر المدلهمة ، والنوازل الشديدة ، والنوائب الفادحة ، والقتل الذريع ، إلى جميع مادهمهم من العذاب والنكال والسوء والأسر والسباء ،
__________________
(٤٠١) ـ الدربندي ، الشيخ آغا بن عابد الشيرواني الحائري : إكسير العبادات في أسرار الشهادات ، ج ١ / ٣٣٣.
وعلمه صلى الله عليه وآله وسلم هذا من شؤون ولايته الكبرى المطلقة العامة الشاملة على كافة البرية.
فالحالة هذه تقتضي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ناظراً طيلة حياته إلى كل تلكم الحوادث ، والرزايا والمصائب الحالة بساحة أهل بيته وأعزائه ، كأنّه كان نظر إليها من وراء ستر رقيق ، وكان مهما نظر على أحد منهم من كثب ، يتجسم بطبع الحال بين عينيه ما كان تحويه هواجسه ، فكان مدى حياته يبدو الحزن والكآبة في أساريره بحكم الطبيعة ، والشجو والأسى لا يفارقانه ، كان مُنَغّص العيش يُسرُّ الزفرة ، ويخفي الحسرة ، ويجرع الغصة ، ومهما وجد جُوّاً صافياً يعالج لوعة فؤاده ، ويطفي لهفة قلبه ، ويخمد نائرة الحزن ، بأن يضم أحداً من أهله على صدره ويشمه ويقبله ، وساكباً عبرته ، فتراه يضم الحسين السبط إليه ويشمه ويقبله ويقبل منه مواضع السيوف والرماح والطعون ، ويخص من جوارحه بالقبلة شفتيه ، علماً منه بأنها ستضربان بالقضيب. يقيم صلى الله عليه وآله وسلم على حسينه وريحانته مأتماً حيناً بعد حين ، في بيوت أمهات المؤمنين ، ومهما إشتد عليه حزنه ؛ يأخذ حسينه على حضنه ويأتي به إلى المسجد إلى مجتمع الصحابه وهو يبكي ، وعيونه تدمع ، ودموعه تسيل ، فيريهم الحسين الرضيع ، وتربة كربلائه في يده ويقول لهم : إنّ أمتي يقتلون هذا ، وهذه تربة كربلاء. أو يأخذ تربته : تربة كربلاء ويشمها ويبكي وفي لسانه ذكر مقتله ومصرعه ، وهو يقول : ريح كرب وبلاء. أو يقول : والذي نفسي بيده إنه ليحزنني ، فمن هذا يقتل حسيناً بعدي؟!
أو يأخذ حسيناً على حجره وفي يده تربته الحمراء وهو يبكي ويقول : يا ليت شعري من يقتلك بعدي؟! ولعل أول حفل تأبين أقيم للحسين الطهر
الشهيد في الإسلام المقدس بدار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولم تسمع أذن الدنيا قبل هذا ، أن ينعقد لمولود ـ غير وليد الزهراء الصديقة في بسيط الأرض ـ مأتم حين ولدته أمه بدلاً من حفل السرور والحبور والتباشير. ولم يقرع قط سمعاً نبأ وليد ينعى به منذ إستهلاله ، حين قدم مستوى الوجود ، بدل نشيد التهاني ، ويذكر من أول ساعة حياته حديث قتله ومقتله ومصرعه.
ولم ينبئ التاريخ من لدن آدم إلى الخاتم ، عن وليد يهدى إلى أبيه عوض هدايا الأفراح تربة مذبحه ، حتى يتمكن منه الحزن في أعماق قلبه وحبة فؤاده. فكأنّ يوم ولادة الحسين له شأن خاص لدى الله العلي العظيم ، ذلك تقدير العزيز العليم ، لم يقدره يوم سرور لآل الله ـ أهل البيت الطاهر ـ وكأنّ الأسى تاءمه في الولادة ، فكدّر صفو العيش ، ونَغّص طيب حياتهم ، واجتث من تلكم البيوت التي أذن الله أن ترفع ، ويذكر فيها اسمه أصول المسرة ، وجعلها لأهلها دار الحزن.
إنّ وفود الملائكة تهبط بإذن ربها يوماً بعد يوم ؛ ومرة بعد أخرى ، في وقت محيّن ، وميعاد معيّن ، وتنعى الحسين العزيز ، ويجدد تأبينه فلاً بعد حفل ، والمأتم ينعقد في بيوت أمهات المؤمنين ، وقد أبكى الله عيون نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه والصحابه الأولين على الحسين ، وتربة كربلاء تنتقل من يد إلى يد ، وأخذت في قارورة كرمز ناطق عن الشهيد المفدى ، في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، بمشهد من الكل ومنظر»(٤٠٢) .
__________________
(٤٠٢) ـ الأميني ، الشيخ عبد الحسين أحمد ، سيرتنا وسنتنا / ٤٣ ـ ٤٨. (بتصرف).
٢ ـ إهتمام الملائكة بالحسين عليه السلام وتربته :
إنّ للحسين عليه السلام مكانه ومنزلة عند الله عَزّ وجَلّ ، وهذا ما نراه واضحاً من غهتمام الملائكة ، ويمكن إيضاح ذلك في مايلي :
أولاً ـ عالم السماء بشكل عام :
إنّ عالم السماء المتمثل في الملائكة ، من المقربين وسكان سدرة المنتهى وغيرهم من أصناف الملائكة ، عرفوا الحسين عليه السلام حق المعرفة ، بعد إطلاعهم على مكانته ومنزلته عند الله عَزّ وجَلّ ، من خلال معرفتهم بوحيه جلّ اسمه ، وهذا ما نستفيده من الروايات التالية :
١ ـ عن الحسين بن علي عليه السلام قال : (دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده أُبي بن كعب ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : مرحباً بك يا أبا عبد الله ، يا زين السماوات والأرضين ، فقال أُبيّ : وكيف يكون يا رسول الله زين السماوات والأرضين غيرك؟ فقال : يا أُبيّ والذي بعثني بالحق نبيّاً (ذِكْرُ) الحسين بن علي في السماء أكبر منه في الأرض ، فإنّه لمكتوب عن يمين عرش الله : مصباح هدى وسفينة نجاة إلخ)(٤٠٣) .
إنّ هذا الحديث واضح وجَلي على مزلة الحسين عليه السلام عند ربه ، وهذا الشعار المقدس ـ ذكر الحسين عليه السلام ـ لا ينمحي أبداً ؛ لأنّ يد القدرة هي التي كتبته ، فهو إعلام وشاهد صدق لا يعتريه الشك والريب ، على أنّ الحسين عليه السلام سار على مخطط إلهي في جهاده واستشهاده ؛ ولذا صار معروفاً عند الملأ الأعلى الملائكة.
__________________
(٤٠٣) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٣٦ / ٢٠٤ ـ ٢٠٥.
٢ ـ ورد في الزيارة عن إمامنا الصادق عليه السلام : (فاستقبل وجهك بوجهه ، وتجعل القبلة بين كتفيك ، ثم قل : السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره ، السلام عليك يا وتر الله الموتور في السماوات والأرض ، أشهد أنّ دمك سكن في الخلد ، واقشعرّت له أظلة العرش ، وبكى له جميع الخلائق ، وبكت له السماوات السبع والأرضون السبع ، وما فيهنّ وما بينهنّ ، ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا ، وما يرى وما لا يرى إلخ)(٤٠٤) .
قال الشيخ المجلسي (قده) : «وقد يطلق الظلال على الأشخاص والأجسام اللطيفة والأرواح ، فيمكن أن يراد بها الأرواح المقدسة ، والملائكة الذين يسكنون العرش ويطيفون به»(٤٠٥) .
وسيأتي زيادة إيضاح في بحث الرؤى ، من الجزء الثالث ، إن شاء الله.
ثانياً ـ إخبارهم بمصرع الحسين (عليه السلام) والإتيان بتربته :
سبق أن ذكرنا في الفصل السابق ، الروايات المتضمنة أنّ الملائكة أتت إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أفواجاً وفرادى حيناً بعد حين ، ومرة بعد أخرى ، ينعون الحسين عليه السلام ويأتون عليه بتربته الطاهرة ، وقد نَصّت بعض الروايات على أسماء بعض الملائكة ، الذين أخبروا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عن مصرع سيد الشهداء منهم : جبرئيل ، وملك البحار ، وملك القطر ، وملك المطر ، وملك إستأذن ربه ، وملك لم يدخل عليّ قط ، وعظيم من عظماء الملائكة. وبقيت بعض الروايات نذكر منها ما يلي :
__________________
(٤٠٤) ـ الكليني ، الشيخ محمد بن يعقوب : الكافي ، ج ٤ / ٥٧٦.
(٤٠٥) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : مرآة العقول ، ج ١٨ / ٢٩٩.
١ ـ ذكر الخوارزمي في كتابه (مقتل الحسين) الرواية التي منها : (ولما أتى على الحسين من ولادته سنة كاملة ، هبط على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إثنا عشر ملكاً محمرة وجوههم ، قد نشروا أجنحتهم وهم يقولون : يا محمد ، سينزل بولدك الحسين ما نزل بهابيل من قابيل ، وسيعطى مثل أجر هابيل ويحمل على قاتله مثل وزر قابيل. قال : ولم يبق في السماء ملك إلا ونزل على النبي يعزيه بالحسين ويخبره بثواب ما يعطى ويعرض عليه تربته ، والنبي يقول : اللهم أخذل من خذله ، واقتل من قتله ، ولا تمتعه بما طلبه إلخ)(٤٠٦) .
٢ ـ في عوالم العلوم : وقال أصحاب الحديث : (فلما أتت على الحسين عليه السلام سنة كاملة ؛ هبط على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إثنا عشر ملكاً على صور مختلفة ، أحدهم على صورة بني آدم يُعزُّونه ويقولون : إنّه سينزل بولدك الحسين بن فاطمة ما نزل بهابيل من (قِبَلِ) قابيل ، وسيعطى مثل أجر هابيل ، ويحمل على قاتله مثل وزر قابيل ، ولم يبق ملك إلا نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعزيه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول : اللهم أخذ خاذله ، واقتل من قاتله ولا تمتّعه بما طلبه)(٤٠٧) .
ثالثاً ـ الملائكة الذين اسأتذنوا لنصرته :
ذكرت بعض الروايات أنّ الملائكة إستاذنته لنصرة سيد الشهداء عليه السلام نذكر منها التالي :
١ ـ عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام : (إنّ أربعة آلاف ملك هبطوا يريدون القتال مع الحسين بن علي عليهما السلام ، فلم يؤذن لهم في القتال ،
__________________
(٤٠٦) ـ الخوارزمي ، أبو المؤيد الموفق بن أحمد : مقتل الحسين ، ج ١ / ١٦٣.
(٤٠٧) ـ البحراني ، الشيخ عبد الله بن نور الله الإصفهاني : عوالم العلوم ، ج ١٧ / ١١٦.
فرجعوا في الإستئذان ، وهبطوا وقد قتل الحسين عليه السلام ، فهم عند قبره شُعث غُبر يبكون إلى يوم القيامة ، ورئيسهم ملك يقال له منصور)(٤٠٨) .
٢ ـ عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : (هبط أربة آلاف ملك يريدون القتال مع الحسين بن علي عليه السلام ، فلم يؤذن لهم في القتال ، فرجعوا في الإستثمار وهبطوا وقد قتل الحسين عليه السلام رحمة الله عليه ولعن قاتله ومن أعان عليه ، ومن شرك في دمه ، فهم عند قبره شُعث غُبر يبكون إلى يوم القيامة ، ورئيسهم ملك يقال له منصور ، فلا يزوره زائر إلا استقبلوه ، ولا يودِّعه مُودِّع إلا شيعوه ، ولا يمرض إلا عادوه ، ولا يموت إلا صلّوا على جنازته ، واستغفروا له بعد موته ، فكلّ هؤلاء في الأرض ينتظرون قيام القائم عليه السلام)(٤٠٩) .
أقول : الذي يبدو أنّ هذين الحديثين حيث واحد ، وإن إختلفت الألفاظ فيهما.
رابعاً ـ الملائكة الحافِّين بقبره الشريف :
لا مانع عقلاً ولا شرعاً أن يكرم الباري عَزَ وجَلّ عباده الصالحين ، بأنواع الفضائل والمناقب ، وعلو الدرجات ، فقد أعطى نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الشفاعة العظمى يوم القيامة ، وكذلك جعل الملائكة في خدمته في الدنيا والآخرة ، وكذلك أهل بيته الأطهار ، ومنهم سيد الشهداء عليه السلام ، ومن الشواهد على ذلك ما ذكرته الروايات التي ذكرتها الطوائف الإسلامية ، في صحاحهم ومسانيدهم ، نذكر منها التالي :
__________________
(٤٠٨) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٤٥ / ٢٢٠.
(٤٠٩) ـ نفس المصدر ، ج ٤٥ / ٢٢٦.
مرويات السنة :
١ ـ وبالإسناد عنهم عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (إن الله يخلق خلقاً كثيراً من الملائكة ، وأنّه ينزل من كل سماء في كل يوم سبعين ألف ملك ، يطوفون بالبيت ليلتهم حتى إذا طلع الفجر ينصرفون إلى قبر النبي فيسلمون عليه ، ثم يأتون قبر علي فيسلمون عليه ، ثم يعرجون إلىا لسماء قبل طلوع الفجر ، ثم ينزل عوضهم في النهار ، ثم يعرجون قبل مغيب الشمس ، والذي نفسي بيده إنّ حول قبر ولدي الحسين أربعة آلاف ملك شعثاً غبراً ، ويبكون عليه إلى يوم القيامة ورئيسهم ملك يقال له منصور ، وأنّ الملائكة عون لمن زاره فلا يزوره زاير إلا إستقبلوه ، ولا يودّعه مودّع إلا شيعوه ، ولا يمرض إلا عادوه ، ولا يموت إلا صلّوا عليه واستغفروا له بعد موته)(٤١٠) .
٢ ـ عن موسى بن علي الرضا بن جعفر قال : سئل جعفر بن محمد عن زيارة قبر الحسين؟ فقال : أخبرني أبي أنّ من زار قبر الحسين ـ عليه السلام ـ عارفاً بحقه ، كتب الله في عليين ، وقال : إنّ حول قبر الحسين سبعين ألف ملك شُعثاً غُبراً ، يبكون عليه إلى يوم القيامة)(٤١١) . خَرّجه أبو الحسن العتيقي.
مرويات الإمامية :
١ ـ عن إسحاق بن عَمّار قال : (قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني كنت بالحيرة ليلة عرفة وكنت أصلي ، وثَم نحو من خمسين ألفاً من الناس جميلة وجوههم ، طيبة أرواحهم ، وأقبلوا يصلون بالليل أجمع ، فلما طلع الفجر سجدت
__________________
(٤١٠) ـ ابن حسنويه ، الشيخ جمال الدين الموصلي : دربحر المناقب / ١٠٧ مخطوط ، عن إحقاق الحق ، ج ٧ / ٣٦٢.
(٤١١) ـ الطبري ، الحافظ محب الدين أحمد بن عبد الله : ذخائر العقبى / ١٥١.
فلما رفعت رأسي ؛ فلم أرَ منهم أحداً؟ فقال لي أبو عبد الله عليه السلام : إنّه مَرّ بالحسين بن علي خمسون ألف ملك وهو يقتل ، فعرجوا إلى السماء فأوحى الله إليهم : مررتم بابن حبيبي وهو يقتل فلم تنصروه؟ فاهبطوا إلى الأرض فاسكنوا عند قبره شُعثاً غُبراً إلى أن تقوم الساعة)(٤١٢) .
٢ ـ عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (ما لكم لا تأتونه ـ يعني قبر الحسين عليه السلام ـ فإنّ أربعة ألف ملك يبكون الحسين إلى يوم القيامة)(٤١٣) .
٣ ـ عن يحيى بن معمر العطّار ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : (أربعة آلاف ملك شُعث غُبر يبكون الحسين إلى يوم القيامة ، فلا يأتيه أحد إلا استقبلوه ، ولا يمرض إلا عادوه ، ولا يموت أحد إلا شهدوه)(٤١٤) .
٤ ـ عن الثمالي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (إنّ الله وكل بقبر الحسين أربعة آلاف ملك ثُعث غُبر ، يبكون من طلوع الفجر إلى زوال الشمس ، وإذا زالت الشمس ؛ هبط أربعة آلاف (ملك) ، فمل يزل يبكونه حتى يطلع الفجر)(٤١٥) .
٥ ـ عن ربعي قال : (قلت لأبي عبد الله عليه السلام بالمدينة : أين قبور الشهداء؟ فقال : أليس أفضل الشهداء عندكم؟ والذي نفسي بيده إنّ حوله أربعة آلاف ملك شُعث غبر ، يبكونه إلى يوم القيامة)(٤١٦) .
هذه بعض الروايات المتعلقة بهذا البحث ، ومن أراد التوسع فعليه بمراجعة الكتب المطوّلة كالبحار ونحوه. والنتيجة التي توصلنا إليها : أنّ إعتناء
__________________
(٤١٢) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٤٥ / ٢٢٦.
(٤١٣) ـ نفس المصدر / ٢٢٢.
(٤١٤) ـ نفس المصدر / ٢٢٣.
(٤١٥) ـ نفس المصدر.
(٤١٦) ـ نفس المصدر.
الملائكة بهذه التربة الطاهرة ، التي سالت عليها دماء أبي عبد الله عليه السلام وأهله وصحبه ، منذ إخبارهم بمصرعه لجده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عدة مرات ، وطلب نصرته من الباري عَزّ وجَلّ وإختلافهم على قبره ؛ لأعظم دليل على منزلة الحسين عليه السلام عند ربهم ؛ لأنّ الملائكة لا يتصرفون إلا بأوامر إلهية.
٣ ـ إهتمام الأنبياء بالحسين وتربته :
س / ذكرت بعض الروايات ، أن هناك علاقة بين الأنبياء وتربة مصرعه ، فما هي هذه الروايات؟
ج / يمكن الإستشهاد بالروايات التالية :
١ ـ روي مرسلاً : (أنّ آدم لما هبط إلى الأرض لم ير حَوّاء فصار يطوف الأرض في طلبها ، فمرّ بكربلاء فاغتمّ وضاق صدره من غير سبب ، وعثر في الموضع الذي قتل فيه الحسين حتى سال الدّم من رجله ، فرفع رأسه إلى السماء وقال : إلهي هل حدث مني ذنب آخر فعاقبتني به؟ فإني طفت جميع الأرض وما أصابني سوء مثل ما أصابني في هذه الأرض. فأوحى الله يا آدم ما حدث منك ذنب ، ولكن يقتل في هذه الأرض ولدك الحسين ظلماً فسال دمك موافقة لدمه ، فقال آدم : يا رب أيكون الحسين نبياً؟ قال : لا ، ولكنه سبط النبي محمد ، فقال : ومن القاتل له؟ قاتله يزيد لعين أهل السماوات والأرض. فقال آدم : فأي شيء أصنع يا جبرئيل؟ فقال : إلعنه يا آدم. فلعنه أربع مرات ، ومشى خطوات إلى جبل عرفات فوجد حوا هناك)(٤١٧) .
__________________
(٤١٧) ـ المصدر السابق ، ج ٤٤ / ٢٤٢.
٢ ـ روي : (أنّ نوحاً لما ركب في السفينة طافت به جميع الدُّنيا ، فلما مرّت بكربلاء أخذته الأرض وخاف نوح الغرق ، فدعا ربه وقال : إلهي طفت جميع الدنيا وما أصابني فزع مثل ما أصابني في هذه الأرض ، فنزل جبرئيل وقال : يا نوح في هذا الموضع يقتل الحسين ، سبط النبي محمد خاتم الأنبياء ، وابن خاتم الأوصياء ، فقال : ومن القاتل له يا جبرئيل؟ قال قائله لعين أهل سبع سماوات وسبع أرضين ، فلعنه نوح أربع مرات ، فسارت السفينة حتى بلغت الجوديّ واستقرت عليه)(٤١٨) .
٣ ـ وروي : (أنّ ابراهيم عليه السلام مَرّ في أرض كربلاء وهو راكب فرساً فعثرت به ، وسقط إبراهيم وشجّ رأسه وسال دمه ، فاخذ في الإستغفار وقال : إلهي أي شيء حدث مني؟ فنزل إليه جبرئيل وقال : يا إبراهيم عليه السلام ما حدث منك ذنب ، ولكن هنا يقتل سبط خاتم الأنبياء وابن خاتم الأوصياء ، فسال دمك موافقة لدمه.
قال : يا جبرئيل ، ومن يكون قاتله؟ قال : لعين اهل السماوات والأرضين ، والقلم جرى على اللوح بلعنه بغير إذن ربه ، فأوحى الله تعالى إلى القلم : إنك استحققت الثناء بهذا اللعن.
فرفع إبراهيم عليه السلام يديه ولعن يزيد لعناً كثيراً ، وأمّن فرسه بلسان فصيح ، فقال ابراهيم لفرسه :أي شيء عرفت حتى تؤمن على دعائي؟ فقال : يا إبراهيم ، أنا أفتخر بركوبك عليّ ، فلما عثرت وسقطت عن ظهري ؛ عظمت خجلتي وكان سبب ذلك من يزيد لعنه الله تعالى)(٤١٩) .
__________________
(٤١٨) ـ المصدر السابق ، ج / ٤٤ ، ٢٤٣.
(٤١٩) ـ نفس المصدر.
وبعد ذكر هذه الرواية ، نطرح السؤال التالي :
س / جاء في الرواية : (والقلم جرى على اللوح بلعنه بغير إذن ربه ، فأوحى الله تعالى إلى القلم : إنك استحققت الثناء بهذا اللعن). فما معنى هذه العبارة ، وكيف يجري القلم بغير إذن ربه؟
أجاب السيد صادق الروحاني (دام ظله) بما يلي :
«اللوح كتاب الله كتب فيه ما يكون إلى يوم القيامة ، والقلم هو الشيء الذي أحدث الله به الكتاب في اللوح ، وجعل اللوح أصلاً لتعرف الملائكة ما يكون ، فإذا أراد الله تعالى أن يطلع الملائكة على غيب له ، أو يرسلهم إلى الإنباء بذلك ، أمرهم بالإطلاع في اللوح فحفظوا منه ما يؤدونه إلى من أرسلوا إليه ، وعرفوا منه ما يعملون. وأفاد الشيخ المفيد أنّه جائت بذلك آثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وعن الأئمة (عليهم السلام) ، وذلك القلم ذو شعور وإرادة ، ولذا ذهب جماعة إلى أنّ اللوح والقلم ملكان ، فالمراد م جريان اللعنة على اللوح بغير إذنه ، الإذن التشريعي لا التكويني ، فألهم القلم باللعنة ؛ ولذا استحق الثناء»(٤٢٠) .
٤ ـ عن خالد الرِّبعي قال : حدثني من سمع كعباً يقول : (أوّل من لعن قاتل الحسين لن علي عليهما السلام إبراهيم خليل الرحمن ، وأمر ولده بذلك وأخذ عليهم العهد والميثاق ، ثم لعنه موسى بن عمران وأمر أمته بذلك ، ثم لعنه داود وأمر بني إسرائيل بذلك ، ثم لعنه عيسى وأكثر أن قال : يا بني إسرائيل إلعنوا قاتله ، وإن أدركتم أيامه فلا تجلسوها عنه ، فإنّ الشهيد معه كالشهيد مع الأنبياء مقبل غير مدبر ، وكأني أنظر إلى بقعته ، وما من نبي
__________________
(٤٢٠) ـ جواب إستفتاء خطي ـ المؤلف.
إلا وقد زار كربلاء ، ووقف عليها وقال : إنك لبقعة كثيرة الخير ، فيك يُدفن القمر الأزهر)(٤٢١) .
لعلّ القارئ الكريم يتسائل ويقول : الرواية ذكرت (أول من لعن قاتل الحسين بن علي عليه السلام ، إبراهيم خليل الرحمن) ، مع العلم أنّ هذا يخالف الروايات السابقة التي ذكرت آدم ونوحاً (عليهما السلام) ، فكيف يكون ذلك؟
لعلّ المستفاد من الرواية أنّ إبراهيم عليه السلام أوّل باعتبار التأكيد والوصية لولده من بعده بلعن يزيد ، وهذا لم يكن للأنبياء الذين سبقوه ، كما هو المستفاد من الروايات.
٥ ـ وروي : (أنّ إسماعيل كانت أغنامه ترعى بشط الفرات ، فأخبره الراعي أنها لا تشرب الماء من هذه المشرعة منذ كذا يوماً ، فسأل عن سبب ذلك؟ فنزل جبرئيل وقال : يا إسماعيل ، سَلْ غنمك فإنّها تجيبك عن سبب ذلك؟ فقال لها : لم لا تشربين من هذا الماء؟ فقالت بلسان فصيح : قد بلغنا أنّ ولدك الحسين عليه السلام سبط محمد يقتل هنا عطشاناً ، فنحن لا نشرب من هذه المشرعة حزنا عليه ، فسألها عن قاتله فقالت : يقتله لعين أهل السماوات والأرضين والخلائق أجمعين. فقال إسماعيل : اللهم إلعن قاتل الحسين عليه السلام)(٤٢٢) .
س / لعلّ القارئ الكريم يتساءل ويقول : حينما سأل إسماعيل عليه السلام ربه عن سبب إمتناع الأغنام عن شرب الماء ، ونزل جبرئيل عليه السلام وقال له : سل غنمك؟ لماذا أحال الجواب على الغنم؟
__________________
(٤٢١) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٤٤ / ٣٠١.
(٤٢٢) ـ نفس المصدر ، ج ٤٤ / ٢٤٣ ـ ٢٤٤.
يمكن أن يجاب عن هذا التساؤل بما يلي :
اولاً ـ إنّ النبي إسماعيل عليه السلام سأل ربه أن يعلمه سبب إمتناع الأغنام من شرب الماء ، فأخبره الوحي : (سل غنمك). فإحالة الجواب للأغنام مع العلم بأنّها بهيمة لا تنطق بفصيح الكلام محل إستغراب وتعجب ، وهذا ما يجعل النبي إسماعيل عليه السلام ومن معه في حالة تأهب واهتمام بما يقال!.
ثانياً ـ إنّ نطق الأغنام بلسان فصيح معجزة لنبيه إسماعيل عليه السلام ، وهذا من الأمور المعروفة في حياة الأنبياء عليهم السلام ، فقد تكلمت الحيوانات للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الكرام عليهم السلام كما هو واضح في تاريخهم ، وهذا النوع من الإعجاز له تأثير على سامعيه.
٦ ـ وروي : (أنّ موسى كان ذات يوم سائراً ومعه يوشع بن نون ، فلما جاء إلى أرض كربلاء إنخرق نعله ، وانقطع شراكه ، ودخل الحَسَك في رجليه وسال دمه ، فقال : إلهي أي شيء حدث مني؟ فأوحى إليه : أنّ هنا يقتل الحسين عليه السلام ، وهنا يسفك دمه ، فسال دمك موافقة لدمه ، فقال : ربِّ ومن يكون الحسين؟ فقيل له : هو سبط محمد المصطفى ، وابن علي المرتضى ، فقال : ومن يكون قاتله؟ فقيل : هو لعين السّمك في البحار ، والوحوش في القفار ، والطير في الهواء ، فرفع موسى يديه ولعن يزيد ودعا عليه ، وأمّن يوشع بن نون على دعائه ومضى لشأنه)(٤٢٣) .
٧ ـ وروي : (أنّ سليمان كان يجلس على بساطه ويسير في الهواء ، فمرَّ ذات يوم وهو سائر في أرض كربلاء ، فأدارت الريح بساطه ثلاث دورات ، حتى خاف السقوط فسكنت الرِّيح ، ونزل البساط في أرض كربلاء. فقال
__________________
(٤٢٣) ـ المصدر السابق ، ج ٤٤ / ٢٤٤.
سليمان للريح : لم سكنتي؟ فقالت : إنّ هنا يقتل الحسين عليه السلام فقال : ومن يكون الحسين؟ فقالت : هو سبط محمد المختار ، وابن علي الكرّار ، فقال : ومن قاتله؟ قالت : لعين أهل السماوات والأرض يزيد ، فرفع سليمان يديه ولعنه ودعا عليه ، وأمّن على دعائه الإنس والجن ، فهبت الريح وسار البساط)(٤٢٤) .
٨ ـ وروي : (أن عيسى كان سائحاً في البراري ومعه الحواريون فمروا بكربلاء ، فرأوا أسداً قد أخذ الطريق ، فتقدم عيسى إلى الأسد فقال له : لم جلست في هذا الطريق؟ وقال : لا تدعنا نَمرّ فيه؟ فقال الأسد بلسان فصيح : إني لم أدع لكم الطريق حتى تلعنوا يزيد قاتل الحسين عليه السلام ، فقال عيسى عليه السلام : ومن يكون الحسين؟ قال : هو سبط محمد النبي الأمي ، وابن علي الولي ، قال : ومن قاتله؟ قال : قاتله لعين الوحوش والذُباب والسباع أجمع ، خصوصاً أيام عاشوراء ، فرفع عيسى يديه ولعن يزيد ودعا عليه ، وأمّن الحواريون على دعائه ، فتنحى الأسد عن طريقهم ومضوا لشأنهم)(٤٢٥) .
٩ ـ عن بريد بن معاوية العِجْلي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : (يا ابن رسول الله ، أخبرني عن إسماعيل الذي ذكره الله في كتابه ، حيث يقول : ( وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ) (٤٢٦) أكان إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام ، فإنّ الناس يزعمون أنّه إسماعيل بن إبراهيم
__________________
(٤٢٤) ـ المصدر السابق.
(٤٢٥) ـ نفس المصدر.
(٤٢٦) ـ مريم / ٥٤.
عليه السلام؟ فقال عليه السلام : إسماعيل مات قبل إبراهيم ، وإنّ إبراهيم كان حُجّة لله قائماً صاحب شريعة ، فإلى من أرسل إسماعيل إذن؟
فقلت : جعلت فداك ، فمن كان؟ فقال عليه السلام : ذاك إسماعيل بن حزقيل النبي ، بعثه الله إلى قومه ، فكذبوه وقتلوه وسلخوا وجهه ، فغضب الله عليهم ، فوجّه إليه اسطاطائيل ملك العذاب ، فقال له : يا إسماعيل ، أنا اسطاطائيل ملك العذاب ، وجّهني إليك ربّ العِزّة لأعذب قومك بأنواع العذاب إن شئت. فقال له إسماعيل : لا حاجة لي في ذلك يا اسطاطائيل فأوحى الله إليه : فما حاجتك يا إسماعيل؟ فقال إسماعيل : يا ربّ ، إنك أخذت الميثاق لنفسك بالربوبية ، ولمحمد بالنبوة ، ولوصيه بالولاية ، وأخبرت خَيْر خلقك بما تفعل أمته بالحسين بن علي عليهما السلام بعد نبيها ، وإنّك وعدت الحسين عليه السلام أن تَكُرَّهُ إلى الدنيا ، حتى ينتقم بنفسه ممن فعل ذلك به ، فحاجتي إليك ـ يا ربّ ـ أن تكرّني إلى الدنيا ، حتى أنتقم ممن فعل ذلك بي كما تُكرُّ الحسين عليه السلام ، فوعد الله إسماعيل بن حَزْقيل ذلك ، فهو يكُرّ مع الحسين بن علي صلوات الله عليهما(٤٢٧) .
أقول : يستفاد من قوله : (أن تَكرّه إلى الدنيا) الرجعة ، وإلى هذا يشير العلامة الأكبر السيد عبد الله شبر (ره) بقوله : «فيجب الإيمان بأصل الرجعة إجمالاً ، وأنّ بعض المؤمنين ، وبعض الكافرين يرجعون إلى الدنيا ، وإيكال تفاصيلها إليهم عليه السلام ، والأحاديث في رجعة أمير المؤمنين والحسين عليهما السلام متواترة
__________________
(٤٢٧) ـ بن قولويه ، الشيخ جعفر بن محمد القمي : كامل الزيارات / ١٣٨ ـ (باب ١٩ ـ حديث ٣).
معنى ، وفي باقي الأئمة قريبة من التواتر ، وكيفية رجوعهم ، هل هو على الترتيب أو غيره؟ فكل علمها إلى الله سبحانه ، وإلى أوليائه عليهم السلام»(٤٢٨) .
وبعد ذكر هذه الروايات ، لعل البعض لا يصدق بما جاء فيها ويقول : إنّ هذه من مبالغات الشيعة في مصرع الحسين عليه السلام ، ومن الشواحد على ذلك ما يلي :
رأي ابن كثير في روايات حادثة كربلاء :
قال : «وللشيعة والرافضة في صفه مصرع الحسين كذب كثير وأخبار باطلة ، وفيما ذكرنا كفاية. وفي بعض ما أوردنا نظر ، ولولا أنّ ابن جرير وغيره من الحفاظ والأئمة ذكروه ما سقته ، وأكثره من رواية أبي مخنف لوط بن يحيى ، وكان شيعياً وهو ضعيف عند الأئمة ، ولكنّه أخباري حافظ ، وعنده من هذه الأشياء ما ليس عند غيره ، ولهذا يترامى عليه كثير من المصنفين في هذا الشأن ممن بعده. والله أعلم»(٤٢٩) .
مناقشة ابن كثير :
مما يؤسف له أنّ مثل هذا الحافظ الذي له أهميته في كتابة التاريخ ، يغلب عليه التعصب والهوى ؛ فإنّ كل من قرأ هذا النص الذي ذكرناه عنه يلاحظ عليه ما يلي :
أولاً ـ الإفتراء على الشيعة بأنها تنقل الكذب الكثير والأخبار الباطلة ، فهذه دعوى لا تغتفر في إتهام طائفة من أكابر الطوائف الإسلامية؟!
ثانياً ـ التشكيك فيما نقله من الأخبار مع إعترافه بنقل الحفاظ والأئمة بذلك ، فبالنتيجة يطعن في علمائه حيث أنّهم ينقلون ما ذكره الشيعة والرافضة من الكذب كما زعم؟!
__________________
(٤٢٨) ـ شبّر ، السيد عبد الله : حق اليقين في معرفة أصول الدين ، ج ٢ / ٥٥.
(٤٢٩) ـ ابن كثير ، عماد الدين إسماعيل بن عمر : استشهاد الحسين / ١٣٠.
ثالثاً ـ الطعن في رواية أبي مخنف لوط بن يحيى باعتبار تشيعه ، وباعتبار ضعفه عند الأئمة ، ثم يذكر أنّه أخبارياً حافظاً ، وأنّ الأئمة أخذوا عنه ، فانظر ـ أيها القارئ الكريم ـ كيف أنّ التعصب والهوى أبعده عن الحقيقة ؛ حيث تورط بتضعيف وتكذيب الشيعة ، وأثبت بعد ذلك أنّ علماءه يأخذون عنهم ، ولا ذنب للشيعة إلا أنهم والوا علياً وولده عليهما السلام ، ولكن هذا التضعيف لا قيمة له في البحث العلمي ، بل هو خلاف العقل والإنصاف. ولو تتبعنا من هو على شاكلته ؛ للاحظنا أنّ منهجهم من قديم الزمان إلى اليوم ، تضعيف الشيعة ورميهم بالكذب ، ومن الشواهد على ذلك ما يلي :
إمام الشافعية يشير إلى هذا المنهج :
إذا في مجلسٍ نذكُرْ علياً |
وسِبطيْهِ وفاطمةَ الزّكية |
|
يُقالُ تجاوزوا يا قومُ هذا |
فهذا منْ حديثِ الرّافضية |
|
برئتُ إلى المُهيمنِ من أناسٍ |
يرون الرّفضَ حُبَّ الفاطميَّة(٤٣٠) |
وقال أيضاً :
قالوا تَرَفّضْتُ قلت : كَلّا |
ما الرّفْضُ ديني ولا إعتقادي |
|
لَكنّ توليتُ غير شكٍّ |
وخيرَ إمامٍ وخيرَ هادي |
|
إن كان حبُّ الوليِّ رفضاً |
فإنّ رفضي إلى العبادِ(٤٣١) |
وهكذا نلاحظ إمام الشافعية من خلال أشعاره يستاء من هذه الظاهرة ، التي نهجتها بعض الجماعات ، والفئات التي عاصرها.
__________________
(٤٣٠) ـ عكاوي ، د. رحاب : ديوان الإمام الشافعي / ١٠٢.
(٤٣١) ـ نفس المصدر / ٤٩.
الدكتور عبد العزيز نور ولي نهج منهج ابن كثير :
وهو من المعاصرين قم بدراسة عنوانها (أثر التشيع على الروايات التاريخية في القرن الأول الهجري) ، ومن النتائج التي توصل إليها ما يلي :
ـ «نجد في الروايات الشيعية التاريخية ، بعض الأمور التي وافقت الروايات الصحيحة ، ولكن مثلهم مثل الكهان ، الذين يأخذون من مسترقي السمع من الشياطين الخبر الصادق ، ويخلطون معه مائة كذبة.
ـ غلاة الشيعة يستغلون بعض الحقائق ليصوغوها بما يوافق هواهم.
ـ يستغل غلاة الشيعة مواطن الإختصار في الروايات الصحيحة ، والتي تكون مجالاً للدس فيها ، فيستغلونها لخدمة عقيدتهم ومذهبهم.
ـ الكم الهائل للروايات الشيعية التي تضمنتها المصادر السنية.
ـ رغم كثرة الروايات التاريخية الشيعية في المصادر التاريخية المعتمدة عند أهل السنة ، إلا أنّ تلك الروايات ؛ كانت أهون بكثير من الروايات التي تناقلتها المصادر الشيعية البحتة.
ـ إعتماد المصادر التاريخية على الروايات الشيعية في حوادث مختلفة من التاريخ ، ولعلّ من أهم الأسباب لهذا الإعتماد الكبير عليها ، عدم الروايات المقابلة التي تعطي التسلسل التاريخي كما تُصوّره الرواية الشيعية.
ـ هذا التشويه والتزييف للتاريخ الإسلامي من قِبَل الشيعة ، تأثر به كُتاب التاريخ قديماً وحديثاً ، فنجد في الروايات المنقولة من طرق ضعيفة ، رغم أنّ رجالها ليسوا شيعة ولكنهم ينقلون ما يوافق روايات الشيعة ، فلا يستبعد تأثرهم بروايات الشيعة.
ـ ضرورة مراجعة كثير من الأخبار المشهورة في التاريخ للتأكد من صحتها ، فليس كل ما هو مشهور صحيحاً.
ـ عدم تجاهل جانب التشيع في غير الغالين فيه ، فرغم غلوهم إلا أنهم ينقلون ما يوافق تشيعهم»(٤٣٢) .
أقول : إنّ صاحب العقل المتجرد من الهوى والعصبية ، يلاحظ أنّ هذا الباحث أقحم نفسه في ميدان علمي لم يستخدم فيه لغة العلم ، بل نراه يتخبط ، فتارة يذهب إلى اعتماد أهل السنة على كثير من المرويات الشيعية ، وتارة أخرى يذهب إلى أنّ الشيعة يستغلون هذه الروايات ، في تصحيح عقيدتهم ومذهبهم.
نعم ، هذا حال تاريخنا الإسلامي وما فيه من الأغاليط ، يشعر بها كل من يقف على أحداثه دارساً ومتأملاً ، وقد ساهم في صنع هذه الأغاليط جماعات من الروات ؛ أعماهم التعصب حتى أفقدهم التوازن الفكري ، غدت حقائق التاريخ على أيديهم سلعة تعرض في (سوق من يزيد أو يريد) ، فهي تظهر حيناً وتختفي حسب الطلب ، ويكثر الوضع إذا إحتدم النزاع بين طائفة وطائفة ، ويقل الوضع حين يخف النزاع ، والوضع تناول كل شيء : الحوادث والحديث والتفسير والأدب وتراجم الرجال ، والتمييز بين المصنوع والمطبوع ، يحتاج إلى حنكة تاريخية وبصيرة نافذة.
٤ ـ تقديس التربة والتبرك بها :
لعلّ من الأشياء التي تُلفت أنظار الآخرين تجاه الشيعة الإمامية ، تلك العلاقة الوثيقة التي تربطهم بكربلاء منذ أزمنة بعيدة ، وإلى يومنا هذا ، اثيرت
__________________
(٤٣٢) ـ نور ولي ، الدكتور عبد العزيز محمد : أثر التشيع على الروايات التاريخية في القرن الأول الهجري / ٤١٣ ـ ٤١٤.
حولها الأسئلة التي يراد بها الوصول إلى الهدف من تقديسها والتبرك بها ، فما هو الهدف الذي دعاهم إلى ذلك؟
يتضح الجواب على هذا السؤال بعد بيان الآتي :
ـ معنى التبرك :
«التبرك : مأخوذ من البَرَكَة وهي : ثبوت الخير الإلهي في الشيء. ولما كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يُحس على وجه لا يحصى ولا يحصر ؛ قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة ، هو مبارك وفيه بركة»(٤٣٣) .
وقد وصف نفسه عَزَ وجَلّ بذلك كما في قوله تعالى : ( فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ) [المؤمنينن / ١٤] ، كل ذلك تنبيهاً على إختصاصه تعالى بالخيرات ؛ أي ثبت الخير عنده وفي خزائنه ، واتسعت رحمته وكثرت نعمته. كما وصف مخلوقاته بذلك في كثير من الآيات ، نذكر منها ما يلي :
١ ـ قوله تعالى : ( وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ ) [مريم / ٣١] ؛ أي موضع الخيرات الإلهية. وفي الحديث عن إمامنا الصادق عليه السلام : (في قول الله عَزَ وجَلّ : ( وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ ) قال : نَفّاعاً)(٤٣٤) .
٢ ـ قوله تعالى : ( ربِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا ) [المؤمنون / ٢٩] ؛ أي حيث يوجد الخير الإلهي.
__________________
(٤٣٣) ـ الإصفهاني ، أبو القاسم الحسين بن محمد : المفردات في غريب القرآن ، ج ١ / ٥٦.
(٤٣٤) ـ الصدوق ، الشيخ محمد بن علي ابن الحسين : معاني الأخبار : ٢١٣.
٣ ـ قوله تعالى : ( وَهَـٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ ) [الأنعام / ٩٢]. قال الشيخ الطبرسي قده : «وإنما سمّاه مباركاً ؛ لأنّه ممدوح مستعد به ، فكلّ من تمسك به نال الفوز»(٤٣٥) .
ـ معنى التقديس :
قال السيد السبزواري (قده) : «والتقديس : بمعنى التنزيه ـ كما عن جمع من اللغويين والمفسرين ـ والتطهير المعنوي عن النقائص. ويمكن التفريق بينهما ، بجعل الأول بالنسبة على الذات الأقدس ، فهو تعالى منزّه عن كل نقص ، والثاني بالنسبة إلى الفعل ففعله منزّه عن كل نقص ، لكونه صادراً عن الحكمة البالغة»(٤٣٦) . هذا بالنسبة للباري عَزّ وجَلّ ، كما وصف نفسه في قوله تعالى : ( لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ ) [الحشر / ٢٤]. أما بالنسبة لخلقه ، فقد جاء في القرآن ذلك كما يلي :
١ ـ قوله تعالى : ( إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ) [النازعات / ١٦].
٢ ـ قوله تعالى : ( يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ) [المائدة / ٢٢].
قال السيد السبزواري (قده) : «ومادة (قدس) تدل على التنزّه والطهر ، يقال : تقدّس الله ؛ أي تنزّه والأرض المقدسة : هي الأرض المطهّرة من رجس الشرك ، والتي يمكن إقامة الدين فها ، ولعلّ هذا هو معنى البركة التي وصف عَزّ وجَلّ الأرض التي وعدهم بها. قال تعالى : ( وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ
__________________
(٤٣٥) ـ الطبرسي ، الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن : مجمع البيان في تفسير القرآن ، ج ٣ ـ ٤ / ٤١٦.
(٤٣٦) ـ السبزواري ، السيد عبد الأعلى الموسوي : مواهب الرحمن في تفسير القرآن ، ج ١ / ١٧٠.
الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ) [الأعراف / ١٣٧]. فإنّ البركة هي : الخير الكثير ، وأعلاه مرتبة ؛ هو إقامة الدين ، وبسط الحق والعدل ، ورفع قذارة الشرك ، وبذلك يمكن الجمع بين كلمات المفسرين في المراد من المقدّسة في المقام. واختلفوا في تعيين الأرض المقدسة ، فقيل : هي الشام ، وقيل : هي الطور وما حوله ، وقيل : أريحاء ، وقال بعضهم : دمشق وفسطين ، وقال آخر : الأردن ، وقيل : غير ذلك.
والحقّ أن يقال : إنه لم يرد في القرآن الكريم ، ولا في السنة الشريفة تحديد هذه الأرض الموعودة ، وإلا أنّ توصيفها بالبركة ـ كما قال تعالى : ( سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ) [الاسراء / ١] ، ـ يقرب أنه المسجد الأقصى وما حوله ، فيستفاد أنّ هذه الأرض المقدّسة ؛ هي هذه المنطقة بالخصوص ، ولعلّ ما ورد في بعض الروايات من أنها الشام ، هو اقرب الإجتماعات ، فإن أرض الشام موصوفة بالبركة عبر العصور ومرّ التاريخ ، وهي تشمل المسجد الأقصى وما حوله»(٤٣٧) .
أدلة التبرك والتقديس
ويمكن الإستدلال على ذلك بثلاثة أدلة وهي كالتالي :
الأول ـ القرآن الكريم :
قال تعالى : ( إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ) [طه / ١٢]. ذكر المفسرون أن السبب الذي لأجله أمر بخلع النعلين فيه قولان :
__________________
(٤٣٧) ـ المصدر السابق ، ج ١١ / ١٢٧ ـ ١٢٨.
الأول ـ أنه أمر بذلك على وجه الخضوع والتواضع ؛ لأنّ التحفي في مثل ذلك أعظم تواضعاً وخضوعاً.
الثاني ـ ليباشر الوادي بقدميه متبركاً به. وهذا يدل على احترام البقعة ، وتعظيم لها وتشريف لقدسها.
الثاني ـ السنة النبوية :
«عن المناسك للكرماني : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رمى جمرة العقبة رجع إلى منزله بمنى ، ثم دعا بالحلاق فأعطاه شقه الأيمن فحلقه ، ثم دفعه إلى أبي طلحة ليفرقه بين الناس ، ثم أعطاه شقه الأيسر فحلقه ، ثم دفعه إلى أبي طلحة ليفرقه بين الناس ، قيل وأصاب خالد بن الوليد شعرات من شعرات ناصيته صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الشفا كانت شعرات من شعره عليه السلام في قلنسوة خالد ، فلم يشهد بها قتالاً إلا رزق النصر انتهى من تاريخ الخميس» ويؤيد ما ذكره الكرماني الأحاديث التالية :
١ ـ عن أنس بن مالك : (أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله أتى منى فأتى الجمرة فرماها ، ثمّ أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق : خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ، ثمّ الأيسر ، ثمّ جعل يعطيه الناس)(٤٣٨) .
٢ ـ عن أنس بن مالك : (لما رمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه. ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ، ثم ناوله الشق الأيسر ، فقال : إحلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال : اقسمه بين الناس)(٤٣٩) .
__________________
(٤٣٨) ـ القشيري ، مسلم ابن الحجاج : صحيح مسلم ، ج ٣ / ٩٤٧.
(٤٣٩) ـ نفس المصدر.
٣ ـ (لما نحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الهدي ، دعا الحلاق وحضر المسلمون يطلبون من شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فأعطى الحلاق شق رأسه الأيمن. ثم أعطاه أبا طلحة الأنصاري ، وكَلّمه خالد بن الوليد في ناصيته حين حلق فدفعها إليه ، فكان يجعلها في مقدمة قلنسوته ، فلا يلقى جمعاً إلا فضه)(٤٤٠) .
وبعد هذا ، هل يحتمل مسلم مؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، أنّ التبرك غير صحيح وخلاف الأحكام الشرعية ، بعد أن حث عليه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ، كما ذكرنا في الروايات؟!
كلا إنّ في التبرك حقيقة التوحيد وخالص الإيمان ؛ إذ أنّ المسلمين يعتقدون بأنّ الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ؛ هو خيرته من خلقه ، والمقرب عنده والمطاع في ملكوته ، وهو عبده ورسوله ، ومبارك من عنده وبإرادته. ومن أراد التوسع ؛ فليراجع الكتب المتخصصة في هذا المجال ، كوفاء الوفاء للسمهودي ، وتبرك الصحابة لمحمد طاهر الكردي ، والتبرك للعلامة الحجة الشيخ علي الأحمدي.
الثالث ـ سِيرَة المسلمين :
قال العلامة محمد طاهر بن عبد القادر : «ولا شك أنّ آثار رسول الله صلى الله عليه وآله ، صفوة خلق الله وأفضل النبيين ، أثبت وجوداً ، وأشهر ذكراً ، وأظهر بركة ، فهي أولى بذلك ـ يعني التبرك ـ وأحرى ، وقد شهدها الجم الغفير من أصحابه ، واجمعوا على التبرك بها ، والاهتمام بجمعها ، وهم الهداة المهديون ، والقدوة الصالحون فتبركوا بشعراته وبفضل وضوئه ، وبعرقه ، وبثيابه وآنيته ، وبمس جسده الشريف بغير ذلك ، مما عرف من آثاره الشريفة التي صحت به الأخبار. فلا جرم إن كان التبرك بها سنة الصحابة رضي الله
__________________
(٤٤٠) ـ الواقدي ، محمد بن عمر : المغازي ، ج ٣ / ١١٠٨ ـ ١١٠٩.
عنهم واقتفى آثارهم في ذلك من نهج نهجهم من التابعين والصالحين. وقد وقع التبرك ببعض آثاره صلى الله عليه وآله وسلم في عهده وأقره ولم ينكر عليه ، فدلّ ذلك دلالة قاطعة على مشروعيته ، ولو لم يكن مشروعاً لنهى عنه وحذّر منه. وكما تدل الأخبار الصحيحة ، وإجماع الصحابة على مشروعيته تدل على قوة إيمان الصحابة وشدة محبتهم ومولاتهم ومتابعتهم للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله على حد قول الشاعر :
أمر على الدِّيار ديار ليلى |
أقبّل ذا الجدار وذا الجدار |
|
وما حب الديار شغفن قلبي |
ولكن حب من سكن الديار(٤٤١) |
وقال العلامة المحقق الشيخ علي الأحمدي (ره) : «التأمل التام في عمل الصحابة رضي الله عنهم ، يمثل لنا عقيدتهم في النبي صلى الله عليه وآله وفي آثاره ، كما أنّ كتب التاريخ والسيرة والحديث تمثل لنا كيف كانوا يعاشرون الرسول صلى الله عليه وآله ، ويقدسونه ويتبركون به في كل شؤونه ؛ إذ من المسلم المقطوع به من أفعال الصحابة الكاشفة عن عقيدتهم في الرسول ، أنّ كل مولود يولد لهم ـ منذ قدومه صلى الله عليه وآله المدينة الطيبة ـ كانوا يأتون به إليه فيحنكه ويمسح رأسه ويتفل في فيه ويباركه يرون أنّه بذلك قد أصبح مباركاً ، وكانوا يتباهون بذلك ويفتخرون به هذا عمل الصحابة ، وأما رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ فكان يقرهم عليه ، ولا ينكر عليهم ذلك. ويعمل به فلو كان التبرك شركاً ؛ لما جرت عليه سيرة الصحابة الذين هم دعاة الدين ورعاته ، ولما اقرهم عليه الرسول العظيم صلى الله عليه وآله ، وبعد هذا
__________________
(٤٤١) ـ عبد القادر ، الشيخ محمد طاهر : تبرك الصحابة / ٥.
فلا يبقى ريب لأي متدبر منصف في ذلك ، بل يدرك المتأمل أنّ ذلك كان من شؤون الإيمان وعلائمه ، ومظاهر اليقين ومناهجه»(٤٤٢) .
نعم هذه سيرة المسلمين جرت على ذلك ، بل يقدسون ويتبركون بكل شيء له صلة بالدين والعقيدة ، كالعلماء والصلحاء ، ومن الشواهد على ذلك ما يلي :
١ ـ الشيخ الإمام السبكي ، وضع حر وجهه على باسط دار الحديث التي مستها قدم النواوي ؛ لينال بركة قدمه ، وينوّه بمزيد عظمته كما أشار إلى ذلك بقوله :
وفي دار الحديث لطيف معنى |
على بسط لها أصبو وآوي |
|
لعلِّي أن أنال بحرِّ وجهي |
مكاناً مَسّه قدم النواوي(٤٤٣) |
٢ ـ «وعاد الشيخ أبو إسحاق إلى بغداد في أقل من أربعة أشهر ، وناظر إمام الحرمين هناك ، فلما أراد الإنصراف من نيسابور ؛ خرج إمام الحرمين للوداع وأخذ بركابه حتى ركب أبو إسحاق ، فظهر له في خراسان منزلة عظيمة. وكانوا يأخذون التراب الذي وطئته بغلته فيتبركون به»(٤٤٤) .
٣ ـ «ولما مات ابن تيمية ؛ كان تشييه حافلاً حتى ضاقت الطريق لجنازته ، وانتهى إليها الناس من كل فج عميق ، واشتد الزحام ، وألقوا على نعشه مناديلهم وعمائمهم للتبرك وكسرت أعواد سريره ؛ لكثرة تعلق الناس به ، وشربوا ماء غسله للتيمن به ، لما اشرب في قلوبهم من حبه ، واشتروا
__________________
(٤٤٢) ـ الأحمدي ، الشيخ علي : التبرك / ١٣ ، ١٨.
(٤٤٣) ـ الفاكهي ، الشيخ عبد القادر : حسن التوسل (المطبوع بهامش كتاب) ـ الإتحاف يحب الأشراف / ٦٠.
(٤٤٤) ـ ابن خلطان ، أحمد بن محمد بن أبي بكر : وفيات الأعيان ، ج ٢ / ١٢٢.
ما زاد من سدره فقسموه بينهم. ويقال : أنّ الخيط الذي كان عليه الزيبق وعُلِّق على جسده لدفع القمل ، اشتروه بمأة وخمسين درهم»(٤٤٥) .
مما تقدم إتضح لنا ، أنّ العادة المألوفة بين المسلمين ، هي التبرك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآثاره في زمانه ، ولم يكن إستنكار منه صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك ، ثم تطور ذلك إلى التقديس والتبرك والإستشفاء بتربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وتربة الحرم والشهداء ، حتى بتربة صهيب الرومي ، وكانت معروفة عند المسلمين في صدر الإسلام. بل تطور الأمر إلى التبرك بموضع أقدام الرجال ، من وضع حَرّ الوجه وتمريغ الجبين على تراب وطئته ، طلباً لليمن والبركة ، إذن فلا غرابة في تقديس الشيعة لتربة الحسين عليه السلام ، التي هي أطيب وأزكى وأطهر تربة ، لما حوته من أجساد أبناء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، الذين هم روحه ونفسه ، وبضعة منه ، ولحمه ودمه ، أيشك في ذلك أحد؟!.
دواعي التبرك والتقديس :
مما سبق يتضح لنا أنّ هناك دواعي للتبرك والتقديس ، نذكر منها ما يلي :
١ ـ إهتمام الباري عَزّ وجَلّ بهذه التربة الطاهرة ، حيث أرسل رسلاً من الملائكة فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبضة منها ، فمن أجل ذلك يحترمها ويأخذها الشيعي ، للتبرك والإستشفاء بها ، والسجود عليها.
٢ ـ إنّ هذه التربة الشريفة ، التي أهداها الجليل عَزّ وجَلّ إلى نبيه الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ، هدية غالية ، لجديرة بأن تُحترم وتُكَرّم إتباعاً لسنة الله تعالى.
٣ ـ إنّ الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ، لما تسلمها من جبريل عليه السلام ، قبّلها وأعطاها لأم سلمة (رض) ـ كما ورد في الروايات ـ فالشيعة يقبلونها عملاً بسنة
__________________
(٤٤٥) ـ ابن كثير ، عماد الدين إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية ، ج ١٤ / ١٣٦ ـ ١٣٨.
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، كما أنهم يحفظونها ، تأسياً برسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث جعلها في قارورة وأعطاها أم سلمة. كما أنّ الإمام الصادق عليه السلام كان يضعها في خريطة ديباج صفراء ، لا يفتحها إلا وقت الصلاة للسجود عليها.
٤ ـ إنّ الشيعة يشمونها كما شَمّها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ، كأغلى العطور والرياحين العطرة ؛ لأنّ شَمّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لها قبل أن يهراق دم الحسين عليه السلام ، إنما هو لعطور معنوية ، وعلاقات ربانية ، وعناية إلهية بالنسبة إليها.
ويقبلونها ؛ لأنّه صلى الله عليه وآله وسلم قَبّلها ، ويسكبون عليها الدموع كما سكب دمعه ، إقتفاء لأثره ، وإتباعاً لسننه كما قال تعالى : ( لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) [الأحزاب / ٢١].
٥ ـ ورد عن أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام من الإهتمام بهذه التربة الطاهرة ، والتبرك بها في تحنيك الأطفال ، وتقبيلها ، ووضعها على العين ، وإمرارها على سائر الجسد ، والإستشفاء والتداوي بها(٤٤٦) .
٥ ـ خصائص التربة الحسينية :
المستفاد من الروايات المتقدمة ، أنّ لهذه التربة الشريفة عدة خصائص ، نذكر منها ما يلي :
١ ـ أنّها مقدّسة مباركة يجعلها الله أفضل أرض في الجنة ، وأفضل منزل ومسكن يسكن فيها أولياءه.
٢ ـ أنّ الله خلقها قبل أن يخلق الكعبة بأربعة وعشرين ألف عام ، وقدّسها وبارك عليها.
__________________
(٤٤٦) ـ استفدت ذلك من العلامة الحجة الشيخ علي الأحمدي ، في كتابه «السجود على الأرض» ـ المؤلف.
٣ ـ عَبّرت عنها الروايات بترعة من ترع الجنة ، وروضة من رياض الجنة ، وأنّها من بطحاء الجنة.
٤ ـ في رواية الإمام زين العابدين عليه السلام : (أنّه إذا زلزلت الأرض زلزالها وسيّرها ؛ رفعت كربلاء كما هي بتربتها النورانية صافية ، فجعلت في أفضل روضة من رياض الجنة ، وأنها لتزهر بين رياض الجنة ، كما يزهر الكوكب الدري ، يغشى أبصارها أهل الجنة ...).
٥ ـ إنّها حرم الله ؛ لما تضمنته من جسد سيد الشهداء وأهل بيته عليهم السلام ، وأنّ التربة المحيطة بقبر الحسين عليه السلام متفاوتة الفضيلة ، من عشرين ذراعاً إلى خمسة فراسخ ، وقد إختارها الله تعالى لمدفنه يوم دحى الأرض.
٦ ـ إنّ هذه التربة قد حملها كل ملك زار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهداها إليه. ففي الرواية : (أنّ كل ملك أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان معه شيء من تربة كربلاء ، وكل نبي زار كربلاء ، فقد قبض منها وشمها ومسّ جلده ترابها ؛ فهي مقام كل الأنبياء إلى يوم القيامة)(٤٤٧) .
٧ ـ قد دفن فيها قبل الحسين عليه السلام مائتا نبي ، ومائتا وصي ، ومائتا سبط كلهم شهداء ، كما في بعض الروايات(٤٤٨) .
٨ ـ زيارة الأنبياء والأوصياء لمكان إستشهاده في كربلاء قبل أن يقتل ، ومن لم يزرها فقد أسري به إليه ، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (اسري به في هذا الوقت إلى موضع من العراق يقال له كربلاء ، فأديت فيه مصرع الحسين ابني وجماعة من ولدي وأهل بيتي ، فلم أزل ألقط دماءهم فها هي في يدي ،
__________________
(٤٤٧) ـ المصدر السابق ، ج ٩٨ / ١١٦.
(٤٤٨) ـ المفيد ، الشيخ محمد بن محمد النعمان : الإرشاد ، ج ٢ / ١٣٠.
وبسطها إليّ فقال : خذيها واحتفظي بها ، فأخذتها فإذا هي شبة تراب أحمر ، فوضعته في قارورة وسددت رأسها)(٤٤٩) .
٩ ـ أنّ الحور العين تستهدي التربة الشريفة من الملائكة النازلين إلى الأرض للتبرك بها.
١٠ ـ إنّ الدفن فيها موجب لدفع العذاب ، والدخول في الجنة بغير حساب.
١١ ـ إنّ السجود عليها يخرق الحجب السبع.
١٢ ـ إنّ الله تعالى جعلها شفاء من كل داء.
١٣ ـ إنّ التسبيح والإستغفار بالسبحة المصنوعة منها ، موجب لمضاعفة الثواب ، وإنّ إدارتها من دون تسبيح يوجب ثواب التسبيح.
١٤ ـ إنّها حرز وأمان من المخاوف إذا حملها الإنسان بهذه النية.
١٥ ـ ورد في الحديث : (حنكوا أولادكم بتربة قبر الحسين عليه السلام فإنّها أمان).
١٦ ـ إنّ وضعها في المتاع موجب للبركة ، كما في بعض الروايات(٤٥٠) .
١٧ ـ إنّ هذه التربة قد إنقلبت دماً أينما كانت منذ انصباب دم الحسين عليه السلام ، بل تتحول في اليوم العاشر من المحرم في كل سنة.
١٨ ـ إنّ شَمّها موجب لإراقة الدموع ، وقد تحقق ذلك قبل مدفنه أيضاً بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام ، وعبروا عنها بريح كرب وبلاء.
١٩ ـ إنّها طيبة الرائحة تفوح كالمسك ، كما ورد في الروايات السابقة ، كما تفوح من قبره رائحة التفاح المهدى له من الجنة ، يجدها المخلص من شيعته ومواليه ، خصوصاً وقت السحر ، كما ورد في بعض الروايات(٤٥١) .
__________________
(٤٤٩) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٤٤ / ٢٣٦.
(٤٥٠) ـ نفس المصدر ، ج ٩٨ / ١٢٤.
(٤٥١) ـ نفس المصدر ، ج ٤٣ / ٢٩٠.
٢٠ ـ ورد إستحباب خلط الحنوط بتربتها الشريفة.
٢١ ـ ورد في الروايات أنّ لونها حمراء أو بيضاء.
٢٢ ـ إنّها من الأماكن التي يحب الله أن يعبد فيها ، كما جاء في حديث الإمام الهادي عليه السلام.
٢٣ ـ إستجابة الدعاء تحت قبة سيد الشهداء عليه السلام ، وهي من الأمور التي عَوّضه الله بها عن قتله.
٢٤ ـ يستحب وضعها مع الميت ، أمام وجه في القبر لرفع عذاب القبر.
هذه بعض خصائص التربة الحسينية ، وقد ذكر قسماً منها المحقق الشيخ جعفر التستري (قده) في كتابه القيم (الخصائص الحسينية).
٦ ـ المجاورة في كربلاء والأماكن المقدسة
تمهيد
١ ـ تعريف المجاورة
٢ ـ أقسام المجاورة
٣ ـ آداب المجاورة
٤ ـ أهداف المجاورة
تمهيد :
إقتضت الحكمة الإلهية ، أن تكون الأرض مجمعاً للخلائق ، ومحلاً لعبادته ؛ إذ فيها الأنبياء والأوصياء والملائكة ، فعلى هذا لها إرتباط بالقوى العلوية ، ومظاهر عالم الغيب ، وترتب على هذا ، أنّ لبعض البقاع مناسبة خاصة لجهة من جهات الغيب ، فكما أنّ ما بين القبر الشريف والمنبر روضة من رياض الجنة ، كذلك هناك بقاع بخلاف ذلك ، وبعد هذا يمكن تقسيم هذه البقاع إلى التالي :
أ ـ المؤتَفِكَات :
«قال البيضاوي : المؤتفكة : القرى التي إئتفكت بأهلها ؛ أي إنقلبت. وقال في النهاية ـ في حديث أنس ـ : البصرة إحدى المؤتفكات ؛ يعن أنّها غرقت مرتين فشبّه غرقها بانقلابها»(٤٥٢) . وبعد هذ التعريف ، تبين لنا أنّ هذه مواضع خسف ، وأنها من المواضع المغضوب عليها ، والتي ذكرها الفقهاء في الأماكن التي يكره الصلاة فيها ، وقد ذكرها السيد بحر العلوم (قده) في منظومته الفقهية :
وفي خصوص أربع مقررة |
وهن ضجنان ووادي الشقرة |
|
يتم في البيداء والصلاصل |
وقد يزداد خامس ببابل(٤٥٣) |
ويمكن إيضاح ما ذكره السيد بحر العلوم (قده) بما يلي :
__________________
(٤٥٢) ـ القمي ، الشيخ عباس : سفينة البحار ، ج ١ / ١٠٠.
(٤٥٣) ـ بحر العلوم ، السيد محمد مهدي : الدُرّة النجفية / ٩٨.
أولاً ـ في الروايات :
نَصّت بعض الروايات على كراهة الصلاة في هذه الأماكن ، نذكر منها التالي :
١ ـ عن معاوية بن عَمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال : (الصلاة تكره في ثلاثة مواضع من الطريق : البيداء ـ وهي ذات الجيش ـ ، وذاب الصلاصل ، وضجناان)(٤٥٤) .
٢ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : (وروي أنّه لا يُصلّي في البيداء ، ولا ذات الصلاصل ، ولا وادي الشقرة ، ولا وادي ضجنان)(٤٥٥) .
ثانياً ـ التعريف بهذه الأماكن :
١ ـ ضَجْنَان :
ذكر الباحثون في تعريفها ما يلي :
أ ـ «قيل : جبيل على بريد من مكة ، وهناك الغَمِيم في أسفله مسجد صلّى فيه رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلّم ، وله ذكر في المغازي ، وقال الواقدي : بين ضَجْنَان ومكة خمسة وعشرون ميلاً ، وهي لأسلم وهذيل وغاضرة.
وقال أبو عبيد البكري : بفتح أوله وإسكان ثانيه على وزن فعلان : جبل بناحية مكة على طريق المدينة. قال ابن عباس : بعث رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم ، أبا بكر بسورة براءة ، فلما بلغ أبو بكر ضجنان ، سمع بغام ناقة علي ثم يقول البكري : ويدلك أنّ بين ضجنان وقُدَيد ليلة ، قول مَعْبد
__________________
(٤٥٤) ـ الحر العاملي ، الشيخ محمد حسن : وسائل الشيعة ، ج ٥ / ١٥٥ (باب ٢٣ من أبواب مكان المصلى ـ حديث ٢).
(٤٥٥) ـ نفس المصدر / ١٥٦ (باب ٢٣ من أبواب مكان المصلي ـ حديث ٥).
ابن أبي مَعْبد الخزاعي ، وقد مَرّ برسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم في غزوة ذات الرّقاع :
قد نَفَرت من رِفْقَتي محمدِ |
وعَجَوةَ من يثرب كالعَنْجدِ |
|
تهوى على دين أبيها الا تلدِ |
قد جعلتْ ماء قُديدٍ موعدي |
وما ضَجْنَان لنا ضُحى الغدِ
قلت : وقوله : وفي أسفله مسجد. لا زال هناك بناء أدركتا بقاياه يستظل بها الإنسان ، وقد اندفن اليوم وكاد ينمحي ، قرب بئر المحسنية من الشمال يرى. ولا شك أنّه هو وقد أهمل واندثر. أما قول معبد : (وماء ضجنان لنا ضحى الغدِ). فإنّ صاحب المطية إذا راح من قديد ؛ يصل ضجناان ضحى الغد»(٤٥٦) .
ب ـ وذكر المقدم عاتق البلادي في معجمه : «حرة مستطيلة من الشرق إلى الغرب ، وينقسم عنها سيل وادي الهَدَةَ ويمرّ بها من مكة إلى المدينة بنعَفِها(٤٥٧) . الغربي على (٥٤) كيلاً ، ويعرف هذا النعف اليوم بخشم المُحْسِنيِّة وكذلك حرة المُحْسِنيِّة ، ولها نعف آخر ينقص شمالاً غربياً يغطيه الرمل ، ذلك هو ما كان يسمى كُرَاعَ الغَميم ويسمى اليوم بَرقاء الغَميم ، أما سبب تسميتها بالمُحْسِنيِّة ؛ فهو أنّ الشريف محسن بن الحسين بن حسن بن أبي نُمَيّ أمير الحجاز ، المتوفى سنة ١٠٣٨ هـ قد بلغه أن خلقاً من الحجاج ماتوا عطشاً في تلك الصحراء التي لا يوجد فيها ماء ، فأمر بحفر بئر سميت (البئر المحسنية) لا زالت تورد ، فأخذت المنطقة إسمها من ذلك»(٤٥٨) .
__________________
(٤٥٦) ـ البلادي ، المقدم عاتق بن غيث : معجم معالم الحجاز ، ج ٥ / ١٩٠ ـ ١٩١.
(٤٥٧) ـ النُّعْف أو النَّعْف : ما ارتفع عن الوادي إلى الأرض وليس بالغليظ. وقيل : ما انحدر عن السطح وغلظ ، وكان فيه صعود وهبوط ، راجع الإفصاح في فقه اللغة ، ج ٢ / ١٠٢٦.
(٤٥٨) ـ البلادي ، المقدّم عاتق بن غيث : معالم مكة التأريخية والأثرية / ١٥٩.
«وكان ضجناان من ديار لحيان من هذيل ، وربما شركتهم فيه خزاعة. أما اليوم فهو من ديار حرب لبني بشر منهم خاصة. غير أنّ ملكية الأرض كانت في عهد ما قبل الدولة السعودية للأشراف ذوي عمرو ، وهم فرع من بني بركات بن أبي نُمَيّ ، ثم صدر قانون الأراضي البور فجعل كل ما ليس حياً مشاعاً»(٤٥٩) .
ج ـ وذكر السيد محمد صالح البحراني في نمارقه : «جبل بناحية مكة ، أهلك الله فيه قوم لوط ، فهو وادٍ من أودية جهنم»(٤٦٠) .
وبعد ذكر هذه التعريفات ؛ نخرج بالنتيجة التالية :
إنّ ما ذكره المُقدّم عاتق البلادي أدق من غيره ، وأقرب إلى الصواب ؛ لأنّه من أدباء مكة المكرمة ، وقد قام بجولات ميدانية لتلك الأماكن ، واعتمد فيها على أهل تلك البقاع في تحديدها ، وذكر أسمائها إلى الوقت الحاضر.
وأما ما ذكره السيد محمد صالح البحراني ؛ فمجمل لا يفيدنا في تحديد الموضع الذي ذكرناه ، إلا أنه تعريف مختصر لما جاء في التاريخ والروايات ؛ حيث جاء في رواية علي بن المغيرة قال : (نزل أبو جعفر عليه السلام في ضجنان ـ وذكر حديثاً يقول في آخره ـ : وإنّه ليقال : إنّ هذا وادٍ من أودية جهنم)(٤٦١) . وقال صاحب الجواهر (قده) : «وضجنان : وادٍ أهلك الله فيه قوم لوط»(٤٦٢) .
__________________
(٤٥٩) ـ المصدر السابق / ١٦٠.
(٤٦٠) ـ البحراني ، السيد محمد صالح الموسوي : النمارق الفاخرة إلى طرائق الآخرة ، ج ٣ / ٨٤.
(٤٦١) ـ الحر العاملي ، الشيخ محمد حسن : وسائل الشيعة ، ج ٥ / ١٥٧.
(٤٦٢) ـ النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام / ج ٨ / ٣٤٩.
٢ ـ وادي الشُقْرَة :
عُرِّف هذا الوادي بما يلي :
أ ـ قال السمهودي : «موضع بطريق فَيْد ، بين جبال حمر ، على ثمانية عشر ميلاً من النخيل ، وعلى يوم من بئر السائب ، ويومين من المدينة ، إنتهى إليه بعض المنهزمين يوم أحد ـ كما رواه البيهقي ـ ومنه قطع كثير من خشب الدوم لعمارة المسجد النبوي بعد الحريق»(٤٦٣) .
ب ـ وقال السيد محمد صالح البحراني : «وهو موضع بطريق مكة فيه شقائق النعمان ، وفيه منازل الجن»(٤٦٤) .
وبعد ذكر هذين التعريفين نستنتج ما يلي :
أولاً ـ قال السمهودي : «بئر السائب : بالطريق النجدي على أربعة وعشرين ميلاً من المدينة ، وبينهما وبين الشُقْرة مثل ذلك ، وبها قَصْر وعمائر وسوق ، وسميت بذلك ؛ لأن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حفرها للناس ، ويقال ، لواديها العرنية ، سَيْلَه يمضي منها فيدفع في الأعواض ، ثم قناة ، والجبل المشرف على بئر السائب يقال له : شباع ، ذكر أهل البادية : «أنّ إبراهيم صلى الله عليه (وآله) وسلّم كان قد نزل في أعلاه قاله الأسدي»(٤٦٥) .
ثانياً ـ جاء في رواية عَمّار الساباطي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : (لا تصلِّ في وادي الشقرة ، فإن فيه منازل الجن)(٤٦٦) . وقال الشيخ ابن إدريس (قده) :
__________________
(٤٦٣) ـ السمهودي ، نور الدين علي بن أحمد : وفاء الوفاء ، ج ٤ / ١٢٤٥.
(٤٦٤) ـ البحراني ، السيد محمد صالح الموسوي : النمارق الفاخرة إلى طرائق الآخرة ، ج ٣ / ٨٤.
(٤٦٥) ـ السمهودي ، نور الدين علي بن أحمد : وفاء الوفاء ، ج ٤ / ١١٣٨ ـ ١١٣٩.
(٤٦٤) ـ الحر العاملي ، الشيخ محمد حسن : وسائل الشيعة ، ج ٥ / ١٥٨. (الباب ٢٦ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢).
«والأولى عندي أنّ وادي الشقرة : موضع بعينه مخصوص ، سواء كان في شقائق النعمان أو لم يكن ، وليس كل وادي فيه شقائق النعمان يكره الصلاة فيه ، بل بالموضع المخصوص فحسب ، وهو بطريق مكة ؛ لأنّ أصحابنا قالوا : يكره الصلاة في طريق مكة بأربعة مواضع ، ومن جملتها وادي الشقرة»(٤٦٧) . وقال صاحب الجواهر (قده) : «بل يؤيده أيضاً تعليل الصادق (عليه السلام) ، النهي عن الصلاة فيه في موثق عَمّار (بأنّ فيه منازل الجن) ، اللهم إلا أن يكون المراد أنهم ينزلون في كل مكان فيه شقائق النعمان ، وهو المراد من وادي الشقرة ، كما عن بعض أصحابنا ، ويؤيده التسامح في أمر الكراهة ، وظهور كون السبب مشغولية القلب ، لكن يمكن كونه المكان المخصوص ، وإن قلنا بعموم الكراهة لذلك ، والأمر سهل»(٤٦٨) .
٣ ـ البَيْدَاء :
ذكرها المؤرخون والباحثون بالتعاريف التالية :
ـ قال ياقوت : «إسم لأرض ملساء بين مكة والمدينة ، وهي إلى مكة أقرب ، تُعدُّ من الشّرَف أمام ذي الحليفة» (٤٦٩). وبعد هذا التعريف عَلّق المقدّم عاتق البلادي : «وفيما تقدم خلط من ياقوت رحمه الله ، وإلا كيف تكون البيداء إلى مكة أقرب ، ثم تعد من الشّرَف أمام ذي الحليفة ، الذي هو حد حرم المدينة؟»(٤٧٠) .
__________________
(٤٦٧) ـ ابن إدريس ، الشيخ أبو جعفر محمد بن منصور : كتاب السرائر ، ج ١ / ٤٦٥.
(٤٦٨) ـ النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج ٨ / ٣٥٠ ـ ٣٥١.
(٤٦٩) ـ الحموي ، ياقوت : معجم البلدان ، ج ١ / ٥٢٣.
(٤٧٠) ـ البلادي ، المقدّم عاتق بن غيث : معجم معالم الحجاز ، ج ١ / ٢٦٤.
ـ وقال المقدم عاتق البلادي : «هي تلك الأرض الجرداء التي تخرج فيها من ذي الحُلَيْفَة جنوباً ، ولم تعد اليوم جرداء ، فقد أنشئت فيها عمائر : إحداها لمعهدٍ تابع لوزارة المعارف ، وبعض معسكرات في طرفها الشمالي ، وستدخل حتماً في عمران المدينة»(٤٧١) .
وقال أيضاً : «ومن يرى البيداء وذا الحليفة على الطبيعة ؛ يعرف أنّ ذا الحليفة يقع في طرف البيداء مما يلي المدينة»(٤٧٢) . وقال السيد أحمد الخيّاري : «وهي صحراء واسعة تقع في الجنوب الغربي من المدينة المنورة ، على بُعد تسعة كيلومترات تقريباً ، البيداء لا ينبت فيها الشجر. والبيداء يفصلها الطريق المؤدي إلى جدة ومكة المكرمة إلى قسمين : جنوبي وشمالي ، وأول البيداء عند آخر ذي الحليفة (المحرم) ، ونهايتها عند الجبال التي خلف محطة (الترنك) التليفون»(٤٧٣) . وقال السيد محمد صالح البحراني : «موضع على ميل من ذي الحليفة مما يلي مكة دون الحفيرة بثلاثة أميال ، يُخْسَف فيها بجيش السفياني ، وتسمى بذات الجيش»(٤٧٤) . وبعد ذكر هذه التعاريف ، نذكر التعريف الذي ذكرته الروايات ، وأهمها رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسين عليه السلام : (إنّا كنّا في البيداء في آخر الليل ، فتوضأت واستكت ، وأنا أهِمّ بالصلاة ثم كأنّه دخل قلبي شيء ، فهل يُصلّى في البيداء في المحمل؟ فقال : لا تصلّ في البيداء. فقلت : وأين حَدّ البيداء؟ فقال : كان جعفر عليه السلام إذا بلغ ذات الجيش جَدّ في السير ، ثم
__________________
(٤٧١) ـ المصدر السابق / ٢٦٣.
(٤٧٢) ـ نفس المصدر / ٢٦٥.
(٤٧٣) ـ الخيّاري ، السيد أحمد ياسين : تاريخ معالم المدينة المنورة / ٢٤٠.
(٤٧٤) ـ البحراني ، السيد محمد صالح الموسوي : النمارق الفاخرة ، ج ٣ / ٨٤.
لا يصلي حتى يأتي مُعَرّس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلت : وأين ذات الجيش؟ فقال : دون الحفيرة بثلاثة أميال)(٤٧٥) .
إيضاح وبيان :
أ ـ مُعَرّس النبي صلى الله عليه وآله وسلم :
ذكر المقدّم عاتق البلادي في معجمه : «قال ياقوت : مسجد ذي الحُلَيْفَة : على ستة أميال من المدينة ، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُعرِّس ثم يرحل لغزاة أو غيرها ، والتَعرِّس : نومة المسافر بعد إدلاجه من الليل ، فإذا كان وقت السحر أناخ ونام نومة خفيفة ، ثم يثور من إنفجار الصبح لوجهته. قلت : وهي بلدة ذي الحليفة ميقات أهل المدينة ومن مَرّ بها ، على (٩ أكيال) جنوب المدينة على طريق مكة ، وتعرف ببيار علي»(٤٧٦) .
ب ـ الحُفَيرَة :
قال المقدم عاتق البلادي : «حَفِير ، بالفتح ثم الكسر : وهو القبر في اللغة. قال ياقوت : وهو موضع بين مكة والمدينة ، قال :
لسلامة دار الحفير كبا |
في الخلق والسحق ، قفار |
الحُفَير : بلفظ التصغير أيضاً ، قال : ياقوت : منزل بين ذي الحُلَيْفَة ومَلَل يسلكه الحاج. وقد تقدم باسم الحَفِير غير مصغر»(٤٧٧) .
__________________
(٤٧٥) ـ الحر العاملي ، الشيخ محمد بن الحسن : وسائل الشيعة ، ج ٥ / ١٥٥ (باب من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١).
(٤٧٦) ـ البلادي ، المقدم عاتق بن غيث : معجم معالم الحجاز ، ج ٨ / ١٩٥.
(٤٧٧) ـ نفس المصدر ، ج ٣ / ٣٥ ـ ٣٦.
أقول : ما ذكره المقدم عاتق البلادي تصحيف للحفيرة ، ويؤيد ذلك ما ذكره السمهودي : «وقال أبو عبد الله محمد بن أحمد الأسدي ، في وصف الطريق بين مكة والمدينة : إنّ من ذي الحُلَيْفَة إلى الحفيرة ستة أميال»(٤٧٨) .
وبعد دراسة ما تقدم ؛ نخرج بالنتيجة التالية :
مما تقدم نستفيد أنّ الروايات ذكرت البيداء وعَبّرَت عنها ذات الجيش ، ومهما إختلف الأسماء وطرأت عليها تصحيفات في تسميتها على مَرّ العصور ، إلا أنّ البقعة المذكورة في الروايات محددة على نحو الإجمال ، ومعروفة وإن كان تحديدها غير دقيق.
٤ ـ صُلاصُل :
ذكر الباحثون في تعريفها ما يلي :
قال السيد أحمد الخيّاري : «صُلصل يبدأ على بُعد سبعة أميال من المدينة المنورة ، ويقال فيه صُلصلان بالتثنية إذا قطعت ميلاً من البيداء التي بعد المحرم (آبار علي) ، فهناك صلصل يبدأ وبه نزول التميم على الراجح من القول»(٤٧٩) .
وقال المقدم عاتق البلادي : «صُلْصُل : هو الحزم الذي تطؤه بعد ذي الحليفة على طريق مكة قبل مفرجات (ذات الجيش) ، ويسمى أيضاً صمد الظمأ»(٤٨٠) .
__________________
(٤٧٨) ـ السمهودي ، نور الدين علي بن أحمد : وفاء الوفاء ، ج ١ / ٩٩.
(٤٧٩) ـ الخيّاري ، السيد أحمد ياسين : تاريخ معالم المدينة المنورة / ٢٤٠.
(٤٨٠) ـ البلادي ، المقدم عاتق بن غيث : معجم معالم الحجاز ، ج ٥ / ١٦٠.
وقال أيضاً : «مُفَرِّحَات : ريمان جنوب المدينة على (٢٤ كيلاً يأخذها طريق مكة ، ترى منها منائر المدينة المنورة. فسموها كذلك لفرحهم عند وصولها برؤية المدينة ، يَنقضّ منها شمالاً شرقياً وادي ذات الجيش الذي يعرف اليوم باسم الشّلَبيّة ، وجنوباً وادي تربان إلى مَلَل»(٤٨١) .
وقال السيد محمد صالح البحراني : «ذات الصلاصل : وهي أرض إختلط رملها بالطين وله صلصلة ؛ موضع بين الحرمين. وقيل : هو اسم الذي أهلك الله فيه النمرود»(٤٨٢) .
وبعد ذكر هذه التعريفات ؛ نستنتج ما يلي :
أولاً ـ عَبّر الباحثون الحجازيون عن (صُلاصُل) بـ(صُلصُل ، وصُلصُلان) وهذا لا يُغير الواقع ؛ إذ حدوث مثل التصحيفات وطلب الخفة وكثرة إستعمال الكلمة كثير في أسماء البقاع ، المهم أنّ الجميع يتفق على حدود البقعة ولو على نحو الإجمال.
ثانياً ـ الملاحظ أنّ المقدم عاتق البلادي ، تارة يُعبر عن (ذات الجيش) بالمُفرّحات ، وتارة يُعبّر عن وادي ذات الجيش بـ(الشَّلَبيَّة). وعَرّف الشَّلَبِيَّة بـ : «تلعة كبيرة شبة وادٍ ، وكانت تعرف بذات الجيش تسيل من ثنايا مفرحات شرقاً ، فتدفع في أبي كَببِير أحد روافد عقيق المدينة من الغرب ، يمر الطريق إلى مكة في قسم منها ، وهناك قرب الطريق (بئر جابر) ربما تكون هي (الحَفِير)
__________________
(٤٨١) ـ المصدر السابق ، ج ٨ / ٢١٩ ـ ٢٢٠.
(٤٨٢) ـ البحراني ، السيد محمد صالح الموسوي : النمارق الفاخرة ، ج ٣ / ٨٤.
ورأس الشَّلَبِيَّة ريع المنجور أحد ثنايا مفرحات ، ويقاسمها الماء من الجهة الأخرى وادي تربان ، فيذهب إلى مَلَل»(٤٨٣) .
والمتأمل في كلامه كأنّما يفرِّق بين ذات الجيش ، ومُفرِّحات ، ووادي ذات الجيش «الشَّلَبِيَّة» ، ومن تأمل ذلك لاحظ أنهما تحديدات لمنطقة واسعة خلاصتها : أنّ البيداء وذات الجيش والشَّلَبِيَّة والمُفَرِّحَات أسماء لهذه البقعة لا أنها مختلفة ومتغايرة ، ومن الشواهد على هذه الدعوى ما يلي :
قال السمهودي : «وقال المطري : هي وسط البيداء ، والبيداء هي التي إذا رَحَل الحُجّاج من ذي الحُلَيْفَة استقبلوها مُصْعِدين إلى جهة الغرب ، وهي على جادة الطريق»(٤٨٤) . ـ إلى أن قال ـ : «وهو موافق لقول من قال : ذات الجيش وادٍ بين ذي الحليفة وتربان : فأطلق اسمها على الوادي التي هي فيه»(٤٨٥) .
ثالثاً ـ ما ذكره السيد محمد صالح البحراني من الترعيف ؛ يلاحظ عليه ما يلي :
١ ـ «ذات الصلاصل : وهي أرض إختلط رملها بالطين وله صلصلة» إنّ هذا التعريف سبقه به صاحب السرائر والمنتهى والشهيد. قال صاحب الجواهر (قده) : «فما عن السرائر والمنتهى من تفسير ذات الصلاصل بأنّها : الأرض لها صوت ودوي. وعن الشهيد من أنّه : الطين الحر المخلوط بالرمل ، فصار صلصالاً إذا جَفّ ؛ أي يصوت. إن كان المراد به التعميم لكل أرض كذلك فلا يخلو من إشكال أو منع ، وإن كان المراد به وجه المناسبة ، وبيان الأصل فلا بأس به»(٤٨٦) .
__________________
(٤٨٣) ـ البلادي ، المقدم عاتق بن غيث : معجم معالم الحجاز ، ج ٥ / ٨٨ ـ ٨٩.
(٤٨٤) ـ السمهودي ، نور الدين علي بن أحمد : وفاء الوفاء ، ج ١ / ٩٨.
(٤٨٥) ـ نفس المصدر / ٩٩.
(٤٨٦) ـ النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج ٨ / ٣٥٠.
٢ ـ وقيل : «هو اسم الذي أهلك الله فيه النمرود». أخذ هذه العبارة من صاحب الجواهر (قده) وهي قوله : «بل قيل : إنّ ذات الصلاصل إسم الموضع الذي أهلك الله فيه النمرود»(٤٨٧) . وهذا قول مجهول قائله ، ولم يعرف مستنده ودليله؟
٥ ـ بَابِل :
«مدينة قديمة في أواسط ما بين النهرين ، تقع أنقاضها على الفرات ، قرب الحِلّة على مسافة (٨٠ كم) ، جنوب شرق بغداد»(٤٨٨) . إمتنع أمير المؤمنين عليه السلام عن الصلاة فيها لما مَرّ بها في طريقه إلى النهروان حتى قطعها ، فغابت الشمس ، فدعا لاله فرجعت الشمس إلى موضعها وقت الصلاة ، وأدى الصلاة فغابت.
ويضاف إلى هذه البقاع (بَرَهُوت) :
قال الحموي : «بَرَهُوت : بضم الهاء ، وسكون الواو وتاء فوقها نقطتان : وادٍ باليمن يوضع فيه أرواح الكفار. وقيل : برهوت بئر بحضر موت. وقيل هو السم للبلد الذي فيه هذه البئر وروي عن علي رضي الله عنه ـ أنّه قال : (أبغض بقعة في الأرض إلى الله عَزَ وجَلّ وادي برهوت بحضر موت ، فيه أرواح الكفار ، وفيه بئر ماؤها أسود منتن تأوي إليه أرواح الكفار) ، وعنه أنّه قال : (شَرُّ بئرٍ في الأرض بئر بلهوت في برهوت ، تجتمع فيه أرواح الكفار)»(٤٨٩) .
ب ـ المرحومات :
وهي البقاع التي ورد مدحها كما في الروايات التالية :
__________________
(٤٨٧) ـ المصدر السابق.
(٤٨٨) ـ اليسوعي ، فردينان توتل : المنجد في الأعلام / ١٠٦.
(٤٨٩) ـ الحموي ، شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت : معجم البلدان ، ج ١ ، ٤٠٥.
١ ـ عن أبي هاشم الجعفري ، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام : (إنّ الله عَزّ وجَلّ جعل من أرضه بقاعاً تسمى المرحومات ، أحبّ أن يدعى فيها فيجيب ، وإنّ الله عَزّ وجَلّ جعل من أرضه بقاعاً تسمى المنتقمات ، فإذا كسب رجل مالاً غير حِلّه ؛ سَلّط عليه بقعة منها فأنفقه فيها)(٤٩٠) .
٢ ـ عبد الله بن بكير ـ في حديث طويل ـ قال : قال أبو عبد الله : (يا ابن بكير ، إنّ الله إختار من بقاع الأرض ستة : البيت الحرام ، والحرم ، ومقابر الأنبياء ، ومقابر الأوصياء ، ومقاتل الشهداء ، والمساجد التي يذكر فيها اسم الله)(٤٩١) .
وبعد هذا التمهيد ؛ إتضحت لنا البقاع المعروفة بالقداسة والطهارة ، وأنّها خير مكان للعبادة واستجابة الدعاء ؛ ولذا نرى جمعاً من العلماء ، يسكنون هذه البقاع طلباً للبركة ، والوسيلة إلى الله عَزّ وجَلّ ، بل هذه سيرة المسلمين منذ بداية العصر الإسلامي إلى يومنا هذا ، فقد إعتنى المسلمون بمسألة المجاورة في إحدى هذه البقاع : مكة المكرمة ، والمدينة المنورة ـ وهي محل إتفاق بين المسلمين ـ ، والنجف الأرض ، والكوفة ، وكربلاء ، وطوس وقم ، وباقي مراقد الأئمة عليهم السلام ، عند الإمامية ، وسيتم بحث مسألة المجاورة حسب التفاصيل الآتية :
١ ـ تعريف المجاورة :
جَاوَرَ مُجَاوَرَة وجوَاراً وجُوَاراً : أقام قرب مسكنه ، ساكنه ، والمسجد إعتكف فيه.
__________________
(٤٩٠) ـ الحر العاملي ، الشيخ محمد حسن : وسائل الشيعة ، ج ٣ / ٥٧٠ (باب ٨ من أبواب أحكام المساكن ـ حديث ٣).
(٤٩١) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٩٨ / ٦٦.
وجَارَ جوَاراً : طلب أن يجار ؛ أي يغاث. وأجار فلاناً : أغاثه(٤٩٢) .
«وفي الدعاء : (يا مَنْ يُجيرُ وَلا يُجارُ عَلَيْهِ) ؛ أي ينقذ من هرب إليه ولا يُنقذ أحدٌ ممن هرب منه. وأجاره الله من العذاب ؛ أنقذه. و (المستجار) من البيت الحرام : هو الحائط المقابل للباب دون الركن اليماني ؛ لأنّه كان قبل تجديد البيت هو الباب ، سمي بذلك ؛ لأنّه يستجار عنده بالله من النار»(٤٩٣) .
وفي دعاء الإمام السجاد : «واجعل في ذلك اليوم مع أوليائك موقفي ، وفي أحبائك مصدري ، وفي جوَارِك مسكني ، يا رب العالمين ». والمراد بجواره تعالى حضرته المقدسة التي ليست بمكان ولا زمان ، بل هي قرب معنوي وعِنْدِيّه روحانية ؛ وهي المشار إليها بقوله تعالى : ( فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ) (٤٩٤) ، ويُعبر عنها بالجنة النورانية الروحانية. وختم الدعاء بقوله عليه السلام : (يا رَبَّ الْعالَمينَ) ؛ أي مالك أمرهم ومبلغهم إلى كمالهم اللائق لمزيد إستدعاء الإجابة ، فإنّ من كان ذلك شأنه وصفته ؛ كان من شأنه إفاضة ما فيه صلاح المربوب ، حتى ينتهي به إلى أقصى غاية الكمال ، وأشرف المراتب والأحوال والله أعلم»(٤٩٥) .
وبعد عرض ما تقدم من معنى المجاورة لغة ، وما ترتب على ذلك من الشواهد القرآنية ؛ تبين لنا أنّ النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وأهل بيته الكرام عليهم السلام ، هم أقرب الخلق وأفضلهم لديه ، وهم وسيلتنا إليه كما قال تعالى : ( وَابْتَغُوا إِلَيْهِ
__________________
(٤٩٢) ـ اليسوعي ، لويس معلوف : المنجد في اللغة / ١٠٩.
(٤٩٣) ـ الطريحي ، الشيخ فخر الدين : مجمع البحرين ، ج ٣ : ٢٥٢ ـ ٢٥٣.
(٤٩٤) ـ القمر / ٥٥.
(٤٩٥) ـ المدني ، السيد علي خان : رياض السالكين ، ج ٧ / ٤١٠.
الْوَسِيلَةَ ) [المائدة / ٣٥]. ومن مصاديق الوسيلة والقرب إلى الله مودتهم وموالاتهم ، ففي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام : (يا عليّ ، من أحبّك وتولّاك أسكنه الله معنا في الجنة. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ * فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ) (٤٩٦) [القمر / ٥٤ ـ ٥٥]. ومن أهم مصاديق الوسيلة مجاورتهم في تلك البقاع الطاهرة ، وبعد هذا التوضيح يمكن تعريف المجاورة بما يلي :
هي سكنى البقاع المقدسة ، والمراقد الطاهرة ، أو الدفن فيها ، طلباً للنجاة والأمان في الدنيا والبرزخ والآخرة.
٢ ـ أقسام المجاورة :
يمكن تقسيم المجاورة إلى قسمين كالتالي :
القسم الأول ـ سكنى البقعة المقدسة :
إعتنى المسلمون بهذا القسم من المجاورة ، إعتماداً على بعض الروايات التي حثت على سكنى هذه البقاع ، لما فيها من القداسة حسب التفصيل الآتي :
أ ـ عند العامة :
بحث علماء العامة هذه المسألة ، وجعلوا موضوعها مكة المكرمة ، والمدينة المنورة ، كما في الأقوال التالية :
الأولى ـ كراهة سكنى مكة :
ذهب الشعبي ، وعبد الرزاق ، وغيرهما ـ كما في وفاء الوفاء ـ إلى ما يلي :
__________________
(٤٩٦) ـ البحراني ، السيد هاشم : البرهان في تفسير القرآن ، ج ٧ / ٣٨٠.
«وعن الشعبي أنّه كان يكره المقام بمكة ويقول : هي دار أعرابية هاجر منها رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلّم ـ ، وقال : ألا يفتي حبيب نفسه يجاور مكة ، وهي دار اعرابية. وقال عبد الرزاق في مصنفه : كان أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلّم ـ يحجون ثم يرجعون ، يعتمرون ثم يرجعون ولا يجاورون»(٤٩٧) .
الثاني ـ كراهة سكنى مكة والمدينة :
نسب هذا القول إلى النووي في شرح مسلم ـ كما ذكر السمهودي ـ : «لكن إقتضى كلام النووي في شرح مسلم حكاية الخلاف فيها ، وكأنّه قاس المدينة على مكة من حيث إنّ عِلّة الكراهية ـ وهي خوف الملل وقلّة الحرمة للأنس وخوف ملابسة الذنوب ؛ لأنّ الذنب بها أقبح ـ نحوه موجود في المدينة ، ولهذا قال : المختار أن المجاورة بهما جميعاً مستحبة ، إلا أن يغلب على ظنه الوقوع في المحذورات المذكورة»(٤٩٨) .
الثالث ـ إستحباب سكنى المدينة :
قال السمهودي : «وبالجملة فالترغيب في الموت في المدينة لم يثبت مثله لغيرها ، والسكنى بها وصلة إليه ؛ فيكون ترغيباً في سكناها تفضيلاً لها على غيرها ، وإختيار سكناها ، هو المعروف من حال السلف ، ولا شك أنّ الإقامة بالمدينة في حياته ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ أفضل إجماعاً ، فنستصحب ذلك بعد وفاته ، حتى يثبت إجماع مثله يرفعه»(٤٩٩) .
__________________
(٤٩٧) ـ السمهودي ، نور الدين علي بن احمد : وفاء الوفاء ، ج ١ / ٥٠.
(٤٩٨) ـ نفس المصدر / ٥١.
(٤٩٩) ـ نفس المصدر ، ج ١ / ٥٠.
وقال الزركشي : «إنّ الظاهر ضعف الخلاف في المدينة ؛ أي لما قدمناه من الترغيب فيها ؛ ولأنّ كل من كره المجاورة بمكة ، إستدل بترك الصحابة الجوار بها ، بخلاف المدينة فكانوا يحرصون على الإقامة بها ـ إلى أن قال ـ وهذا كله متضمن للحث على سكنى المدينة ، وتفضيله على سكنى مكة ـ وهي جدير بذلك ـ ؛ لأنّ الله تعالى إختارها لنبيه ـ صلى الله عليه وآله وسلّم ـ قراراً ، وجعل أهلها شيعة له وأنصاراً ، وكانت لهم أوطاناً ، ولو لم يكن إلا جواره (صلى الله عليه وآله وسلم) بها ، وقد قال (صلى الله عليه وآله وسلم) : (ما زال جبريل يوصيني بالاجر) الحديث ولم يخصّ جاراً دون جار ، ولا يخرج أحد عن حكم الجار وإن جار ؛ ولهذا إخترتُ تفضيل سكناها على مكة ، مع تسليم مزيد المضاعفة لمكة ؛ إذ جهة الفضل غير منحصرة في ذلك ، فتلك لها مزية العدد ، ولهذه تضاعف البركة والمدد ، ولتلك جوار بيت الله ، ولهذه جوار حبيب الله وأكرم الخلق على الله ، وسرّ الوجود والبركة الشاملة لكل موجود»(٥٠٠) .
ب ـ عند الإمامية :
إنّ عنوان المجاورة عند الشيعة الإمامية أوسع من غيرهم ؛ حيث يشمل مكة المكرمة ، والمدينة المنورة ، وباقي البقاع المقدسة ، وقد بحثها الفقهاء كالتالي :
١ ـ مكة المكرمة :
إختلف الفقهاء في المجاورة بمكة المكرمة على قولين :
الأول ـ الإستحباب :
قال الفاضل المقداد (قده) : «والأصح إستحباب المجاورة بها للواثق من نفسه بعدم هذه المحذورات ، وبه يجمع بين الروايات الدالة على الإستحباب
__________________
(٥٠٠) ـ المصدر السابق / ٥٢.
والكراهية. وفهم من قال : إن جاور للعبادة استحبت ، وإن جاور للتجارة كره ، وهو جمع حسن بين الروايات»(٥٠١) .
وقال الشهيد الثاني (قده) : «وهذه الأخبار تدل على إستحباب الإقامة فيتعارض الأخبار ظاهراً ، وجمع الشهيد (رحمه الله) ، وجماعة بينها بحمل الكراهية على من لا يأمن وقوع لهذه المحذورات منه ، والإستحباب للواثق من نفسه بعدمها. ويشكل بأنّ بعضها غير إختياري ، كالتأسي بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) ، وكونه أخرج منها كرهاً. وجمع آخرون بحمل الأخبار الأخيرة على المجاورة لأجل العبادة ، والأولى على المجاورة لا لها كالتجارة.
وهو حسن مع الوثوق بعدم الملل والإحترام ، وملابسة الذنب ونحوه»(٥٠٢) .
الثاني ـ الكراهة :
قال الفاضل المقداد (قده) : «هنا سؤال : مكة أشرف البقاع لتظافر الروايات بذلك ، فلا يتناسب كراهة المجاورة بها؟
جواب : الكراهية ليست باعتبار نفس المجاورة بل بإعتبار آخر ، وذُكِرَ وجوه :
١ ـ خوف الملالة وقلّة الإحترام.
٢ ـ حذر ملابسة الذنب ، فإنّ الذنب بها أعظم ، قال الصادق (عليه السلام) : (كل الظلم فيه إلحاد حتى ضرب الخادم) ، قال : ولذلك كره الفقهاء سكنى مكة.
__________________
(٥٠١) ـ السيوري ، الشيخ مقداد بن عبد الله : التنقيح الرّائع لمختصر الشرائع ، ج ١ / ٥٢١.
(٥٠٢) ـ الشهيد الثاني ، الشيخ زين الدين بن علي العاملي : مسالك الأفهام ، ج ٢ / ٣٨٠.
٣ ـ ليدوم شوقه إليها أشرع خروجه منها ، ولهذا ينبغي الخروج منها عند قضاء المناسك.
٤ ـ روي أن المقام بها يقسي القلب(٥٠٣) .
وقال الشهيد الثاني (قده) : ـ شارحاً عبارة الشرائع ـ «ويكره المجاورة بمكة» ـ بمعنى الإقامة بها بعد قضاء المناسك وإن لم يكن سنة ، وكلاهما مروي في الصحيح ، ومع الثاني أنّه المتعارف ، وقد عُلّل ذلك بوجوه كلها مروية :
الأول ـ أنّ المقام بها يقسي القلب ، رواه الصدوق في العلل ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : (إذا قضى أحدكم نسكه ؛ فليركب راحلته وليلحق بأهله ، فإنّ المقام بمكة يقسي القلب).
الثاني ـ مضاعفة العذاب بسبب ملابسة الذنب فهيا ، فقد روي فيه أيضاً بإسناده إلى أبي الصباح الكناني ، قال : (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عَزّ وجَلّ : ( وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) (٥٠٤) . فقال (عليه السلام) : كل ظلم يظلم فيه الرجل نفسه من سرقة ، أو ظلم أحد ، أو شيء من الظلم فإني أراه إلحاداً حتى ضرب الخادم ، ولذلك كان ينهى أن يسكن الحرم)/.
الثالث ـ خروج النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) منها قهراً وعدم عوده إليها إلا للنسك ، وإسراعه الخروج منها حين عاد ، روى ذلك أيضاً عنه (عليه السلام) : (أنّه كره المقام بمكة ، وذلك أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله
__________________
(٥٠٣) ـ السيوري ، الشيخ مقداد بن عبد الله : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ، ج ١ / ٥٢٠ ـ ٥٢١.
(٥٠٤) ـ الحج / ٢٥.
وسلّم) أخرج عنها ، ويقسو قلبه حتى يأتي في غيرها) وروى محمد بن مسلم ، عن الباقر (عليه السلام) قال : (لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة ، قلت : كيف أصنع؟ قال : يتحول عنها إلى غيرها).
وعلل أيضاً بخوف الملالة وقلّة الإحترام ، وليدون شوقه إليها ، وهو منقوض بالمدينة ، فإنّ المجاورة بها مستحبة مع وجود العلل فيها؟ إلا أن يقال : إنّ ذلك في مكة أزيد بسبب زيادة المشقة في الإقامة بها ـ إلى أن قال ـ وإن كان المشهور الكراهة مطلقاً»(٥٠٥) .
٢ ـ المدينة المنورة :
قال صاحب الجواهر (قده) : «لا خلاف ولا إشكال في أنّه (تستحب المجاورة بها) ؛ أي بالمدينة ، بل في الدروس الإجماع عليه ؛ للتأسي ، ولما ورد في مدحها ودعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها ، ولما نستتبعه من العبارات فيها»(٥٠٦) .
٣ ـ كربلاء المقدسة :
وردت الروايات الكثيرة في فضل هذه البقعة الطاهرة ، كما أنّ جمعاً من العلماء والأتقياء سكنوا كربلاء ، ومن أوائل من سكن كربلاء ؛ هو السيد ابراهيم المجاب ، وقد كانت الحوزة العلمية في كربلاء لفترة من الزمن ، ومع هذا فإنّ العلماء إختلفوا في سكنى كربلاء على قولين :
الأول ـ الإستحباب :
وقد أشار إلى هذا الشيخ المامقاني (قده) : «ولعلّ ما يظهر منه فضل السكنى بها مختص بمن لسكناه مدخل في عمارة القبر ، وكان سكناً له
__________________
(٥٠٥) ـ الشهيد الثاني ، الشيخ زين الدين بن علي العاملي : مسالك الإفهام ، ج ٢ / ٣٧٩ ـ ٣٨١.
(٥٠٦) ـ النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج ٢٠ / ١٠٣.
للزيارة ، وكان من أهل التقوى والعبادة ، دون من اتخذه وطناً يرتكب فيها ما يرتكب في ساير البلاد من المحرمات والمكروهات ـ أعاذنا الله تعالى من ذلك ـ فإنّ الذنب في الأمكنة الشريفة ، أشدّ خطراً وأعظم عقوبة منه في ساير الأمكنة ، فالله الله في ذلك»(٥٠٧) .
الثاني ـ الكراهة :
قال الشيخ المامقاني (قده) : «ولكن مع ذلك فقد ورد النهي عن إتخاذها وطناً ، فعن مولانا الصادق (عليه السلام) أنه قال : (إذا زرت الحسين ؛ فزره وأنت مكروب ، وأشعت مغبر جائع عطشان ، فإنّ الحسين قتل حزيناً ومكروباً شعتاً مغبراً جائعاً عطشاناً ، واسأله الحوائج وانصرف عنه ، ولا تتخذه وطناً»(٥٠٨) .
القسم الثاني ـ الدفن فيها :
إنّ مسألة الدفن في جوار أحد المعصومين عليهم السلام ، أو النقل إلى مشاهدهم المشرفة ، من المسائل التي دارت حولها المناقشات بين مؤيّد ومعارض ، وقد أشار إلى ذلك الشيخ ال أميني (قده) بقوله : «لقد كثرت الجبلة واللغط حول هذه المسألة من أناس جاهلين بمواقع الأحكام ، ذاهلين عن مصار الفتيا ، حسبوا أنّها مختصات الشيعة فحسب ، ففوّقوا إليهم نبال الطعن ، وشنُّوا عليهم الغارات ، وهناك أغرار تصدّوا للدفاع ـ وهم مشاركون لأولئك في الجهل أو الذهول ـ بأنّها من عمل الدهماء ، فلا يُحتجُّ بها على المذهب أو العلماء ، وآخر حَرّف الكلم عن مواضعه إبتغاء إثبات أمنيّته ، ولكن وراء الكل حُذّاق
__________________
(٥٠٧) ـ المامقاني ، الشيخ عبد الله : مرآة الكمال ، ج ٣ / ٢٥٩ ـ ٢٦٠.
(٥٠٨) ـ نفس المصدر / ٢٥٩.
البحث كشفوا عن تلك السوءات»(٥٠٩) وبعد هذا ، سنعرض هذه المسألة على البحث ، ليتضح لنا رأي علماء المسلمين فيها كالتالي :
أ ـ عند العامة :
أما آراء علماء العامة ؛ فهي كالتالي :
١ ـ المالكية ـ قالوا : يجوز نقل الميت قبل الدفن وبعده من مكان إلى آخر بشروط ثلاثة :
أولها ـ أن لا ينفجر حال نقله.
ثانيها ـ أن لا تهتك حرمته ، بأن ينقل على وجه يكون فيه تحقير له.
ثالثها ـ أن يكون نقله لمصلحة ، كأن يخشى من طغيان البحر على قبره ، أو يراد نقله إلى مكان قريب من أهله ، أو لأجل زيارة أهله إياه ، فإن فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة حرم النقل.
٢ ـ الحنفية ـ قالوا : يستحب أن يدفن الميت في الجهة التي مات فيها ، ولا بأس بنقله من بلدة إلى أخرى قبل الدفن عند أمن تغير رائحته ، أما بعد الدفن فيحرم اخراجه ونقله ، إلا إذا كانت الأرض التي دفن فيها مغصوبة ، أو أخذت بعد دفنه بشفعة.
٣ ـ الشافعية ـ قالوا : يحرم نقل الميت قبل دفنه من محلّ موته إلى آخر ليدفن فيه ولو أمن تغيره ، جرت عادتهم بدفن موتاهم في غير بلدتهم ، ويستثنى من ذلك من مات في جهة قريبة من مكة ، أو المدينة المنورة ، أو بيت المقدس ، أو قريباً من مقبرة قوم صالحين ، فإنه يسنّ نقله إليها إذا لم يخش تغير رائحته ، وإلا حرم ، وهذا كله إذا كان قديم غسله وتكفينه
__________________
(٥٠٩) ـ الأميني ، الشيخ عبد الحسين : الغدير ، ج ٥ / ٦٦.
والصلاة عليه في محلّ موته ، وأما قبل ذلك فيحرم مطلقاً ، وكذلك يحرم نقله بعد دفنه إلا لضرورة ، كمن دفن في أرض مغصوبة فيجوز نقله إن طالب بها مالكها.
٤ ـ الحنابلة ـ قالوا : لا بأس بنقل الميت من الجهة التي مات فيها إلى جهة بعيدة عنها ، بشرط أن يكون النقل لغرض صحيح ، كأن ينقل إلى بقعة شريفة ليدفن فيها ، أو ليدفن بجوار رجل صالح ، وبشرط أن يؤمن تغير رائحته ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون قبل الدفن أو بعده(٥١٠) . هذه أقوال علماء المذاهب الأربعة في جواز النقل في الصورتين ـ أي قبل الدفن وبعده ـ كما أنّ المستفاد من كلماتهم نقل الجثة إلى البقاع الشريفة من أرض بيت الله الحرام ، أو جوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أو جوار إمام مذهب ، أو مرقد ولي من الأولياء ونحو ذلك ، حسب الشروط التي ذكروها.
ب ـ عند الإمامية :
وبحث علماء الشيعة الإمامية هذه المسألة كالتالي :
١ ـ السيد شرف الدين :
وكتب السيد عبد الحسين شرف الدين (قده) في مقالة عنوانها : (نقل الأموات) في أحد أعداد مجلة العرفان الصيداوية(٥١١) ، رد بها على السيد هبة الدين الشهرستاني الذي حرم النقل بكل صورة قال : «نقل الأموات إما قبل الدفن أو بعده إلى أحد المشاهد المقدسة أو إلى غيرها ، فهنا أربع مسائل :
__________________
(٥١٠) ـ الجزيري ، عبد الرحمن بن محمد : كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ، ج ١ / ٤٦٩.
(٥١١) ـ مجلة العرفان الصيداوية ، ج ٣ / ٨٩٧.
المسألة الأولى : نقلهم قبل الدفن إلى أحد المشاهد المشرفة فإنه مستحب عندنا ـ كما في كشف اللثام ، وفي مفتاح الكرامة نقلاً عن التذكرة والذكرى ، وجامع المقاصد ، والروض ـ ؛ كان عليه عمل الإمامية من زمن الأئمة (عليهم السلام) إلى الآن من غير تذاكر إجماعاً.
والمسألة الثانية : نقل الأموات قبل دفنهم إلى غير المشاهد المشرفة والحكم في هذه المسألة الجواز على كراهة بلا خلاف بين الأصحاب ، وتراهم يرسلون الكراهة ـ هنا ـ إرسال المسلمات ، بل في مفتاح الكرامة : نقلاً عن التذكرة ، ونهاية الأحكام ، والذكرى ، وجامع المقاصد ، وشرح الجعفرية ، والمفاتيح ، الإجماع على كراهة فيها.
المسألة الثالثة : نقل الأموات بعد دفنها إلى أحد المشاهد المقدسة ، والمشهور بين أصحابنا فيها الحرمة ، كما عن المسالك ، والروض ، والكفاية ، والتذكرة ، والمنتهى ، والقواعد ونهاية الأحكام ، والتلخيص ، والسرائر ، والشرائع ، والذكرى ، والبيان.
والمسألة الرابعة : نقل الأموات بعد دفنهم إلى غير المشاهد المشرفة ، وهذا محرم».
٢ ـ السيد اليزدي :
ذكر السيد اليزدي (قده) في العروة في فصل مكروهات بعد الدفن ما يلي :
«نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر إلا إلى المشاهد المشرفة ، والأماكن المقدسة ، والمواضع المحترمة ، كالنقل من عرفات إلى مكة ، والنقل إلى النجف الأشرف ، فإنّ الدفن فيه يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين ، وإلى كربلاء والكاظمية وسائر قبور الأئمة (عليهم السلام) ، بل إلى مقابر العلماء والصلحاء ،
بل لا يبعد إستحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجحات الشرعية. والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده ، ومن قال بحرمة الثاني ؛ فمراده ما إذا إستلزم النبش ، وإلا فلو فرض خروج الميت عن قبره بعد دفنه بسبب ـ من سبع أو ظلم؟أو صبّي أو نحو ذلك ـ لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلاً. ثم لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرفة ، وإن استلزم فساد الميت إذا لم يوجب أذية المسلمين ، فإن من تمسك بهم فاز ، ومن أتاهم فقد نجا ، ومن لجأ إليهم أمن ، ومن إعتصم بهم فقد إعتصم بالله تعالى ، والمتوسل بهم غير خائب ، صلوات الله عليهم أجمعين»(٥١٢) .
٣ ـ السيد الحكيم :
قال السيد الحكيم (قده) : «يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر إلا المشاهد المشرفة ، والمواضع المحترمة ، فإنّه يستحب ولا سيما الغري والحائر. ومن خواص الأول إسقاط عذاب القبر ، ومحاسبة منكر ونكير» ، وقال أيضاً : «لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدفن وما بعده إذا إتفق تحقق النبش ، بل لا يبعد جواز النبش لذلك إذا كان بإذن الولي ، ولم يلزم هتك حرمة الميت»(٥١٣) . وهذا الرأي عليه كثير من المعاصرين.
فروع فقهية
كما أنهم ذكروا فروعاً فقهية على هذه المسألة نذكر منها ما يلي :
__________________
(٥١٢) ـ اليزدي ، السيد محمد كاظم الطباطبائي : العروة الوثقى / ١٥٠ ـ ١٥١.
(٥١٣) ـ الحكيم ، السيد محسن الطباطبائي : منهاج الصالحين ، ج ١ / ٥٧.
١ ـ قال السيد الخوئي (قده) : «يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده ، إلا مع العلم باندراسه ، وصيرورته تراباً ، من دون فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون ، ويستثنى من ذلك موارد :
منها : ما إذا كان النبش لمصلحة الميت ، كالنقل إلى المشاهد ، كما تقدم»(٥١٤) .
٢ ـ قال السيد اليزدي (قده) : «من الأمكنة التي يستحب الدفن فيها ويجوز النقل إليها الحرم ، ومكة أرجح من سائر مواضعه ، وفي بعض الأخبار أنّ الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر ، وفي بعضها إستحباب نقل الميت من عرفات إلى مكة المكرمة»(٥١٥) .
٣ ـ قال السيد الخوئي (قده) : «لا يجوز التوديع المتعارف عند بعض الشيعة (أيدهم الله تعالى) بوضع الميت في موضع والبناء عليه ، ثم نقله إلى المشاهد الشريفة ، بل اللازم أن يدفن بمواراته في الأرض ، مستقبلاً بوجهه القبلة على الوجه الشرعي ، ثم ينقل بعد ذلك بإذن الوليّ على نحو لا يؤدي إلى هتك حرمته»(٥١٦) . وعلى هذا الرأي جمع من الفقهاء المعاصرين.
٤ ـ قال السيد السبزواري (قده) : «قد تعارف في هذه الأعصار نقل الجنائز من أطراف كربلاء حتى من النجف والتبرك بها بالضريح المقدس الحسيني ، ثم دفنها في النجف الأشرف ، ومقتضى الأصل جوازه لو لم يترتب عليه حرام ، والظاهر عدم إحتساب مؤنة النقل على القُصّر من الورثة ، ويشهد له في
__________________
(٥١٤) ـ الخوئي ، السيد أبو القاسم الموسوي : منهاج الصالحين ، ج ١ / ٩٤.
(٥١٥) ـ اليزدي ، السيد محمد كاظم الطباطبائي : العروة الوثقى / ١٥٣.
(٥١٦) ـ الخوئي ، السيد أبو القاسم الموسوي : منهاج الصالحين ، ج ١ / ٩٥.
الجملة ما ورد في وصية الحسن لأخيه الحسين (عليه السلام) ، من حمل نعشه إلى حرم النبي (صلى الله عليه وآله) ليجدد به عهداً ، ثم دفنه في البقيع»(٥١٧) .
٥ ـ قال الشيخ الميرزا جواد (دام ظله) : «المجاورة في الكوفة القديمة الشاملة للنجف وكربلاء والكاظمين ، أفضل من المجاورة في مكة المكرمة ، كما ورد في بعض الروايات ، والله العالم»(٥١٨) .
٦ ـ قال الشيخ الميرزا جواد (دام ظله) في جواب السؤال التالي :
«ذكر الشهيد الأول (قده) في (القواعد والفوائد) أنّ مذهب الأصحاب ، أنّ مكة زادها الله شرفاً أشرف بقاع الأرض ، وأفضلها. وقال السيد بحر العلوم (قده) في الدرّة :
ومن حديث كربلاء والكعبة |
لكربلاء بان علوّ الرتبة |
وهل مكة أفضل أم المدينة؟ بيّنوا لنا الصواب في ذلك؟
بسمه تعالى : إذا كان الغرض من السؤال من الأشرفية قصد المجاورة في المكان ، فمجاورة النجف وكربلاء أفضل ، وكذا إذا كان الغرض من السؤال الزيارة ؛ فزيارة كربلاء أفضل ، وأما بالنسبة لخلق الأرض أولاً ؛ فمكة بالنسبة لخلق الأرض أشرف البقاع ، ويظهر منها إمام العصر عليه السلام. وقد ظهر مما تقدم أنّ المجاورة بالمدينة أفضل ، والله العالم»(٥١٩) .
__________________
(٥١٧) ـ السبزواري ، السيد عبد الأعلى الموسوي : مهذب الأحكام ، ج ٤ / ٢٣٩.
(٥١٨) ـ التبريزي ، الشيخ الميرزا جواد : صراط النجاة ، ج ٦ / ٣٩٢.
(٥١٩) ـ نفس المصدر ، ج ٥ / ٢٨٩.
٣ ـ آداب المجاورة :
ينبغي للساكن في البقاع الطاهرة المجاورة فيها أن يراعي قدسيتها ، بل يجتهد في مراعات الآداب وحرمة من ثوى فيها من الأنبياء والأوصياء ، فإنّ حرمتهم أموات كحرمتهم أحياءاً ، فليحذر المعاصي فيها ، فإنّ الآتي بالمعصية فيها يتضاعف إستحقاقه العقوبات ؛ لهتكه لحرمة هذه البقاع المقدسة ، واحترام من حلّ بها ، ولذا لا بد أن يكون المجاور صاحب بصيرة تامة وملكة نورانية ، حتى يعرف هذه البقاع المقدّسة وقدر من حلّ بها ؛ ومن تتبع سيرة الماضين من العلماء الأخيار ، والفضلاء الأبرار ، كانوا في كربلاء المقدسة يجتنبون عن إتيان المكروهات ، بل كان جمع منهم لا يبولون ولا يتغوطون في هذه الأرض ، بل في آنية كالحباب والمراكن ونحوها ، ثم كانوا يحملونها إلى المكان الذي يخرج من حدود كربلاء ، ثم إنّ جمعاً لم يدخلوا الحرم إلا بعد كمال الخشوع ، وحضور القلب وجريان الدموع.
ومن الشواهد على ذلك ، ما ذكره الفاضل الدربندي (قده) : «وقد سمعت حكاية عجيبة ، وواقعة غريبة وقعت قبل خمسين سنة(٥٢٠) من هذا الزمان وحاصلها ؛ أنّ رجلاً من عظماء بلاد الهند وفد إلى كربلاء ، ومضت من وروده إلى كربلاء مدة ستة أشهر ، وهو لم يحضر الحرم الشريف ، بل متى ما يريد يقول : السلام على سيد الشهداء ، كان يصعد فوق سطح المنزل الذي كان فيه ، فيزوره ويسلم عليه من ذلك المكان ، وقد بلغ خبره النقيب في ذلك الزمان ـ وهو السيد الأجلّ المرتضى ـ ؛ فجاء السيد المرتضى إلى منزله فعاتبه
__________________
(٥٢٠) ـ الأقرب إلى الصحة ، قبل (٧٥٠ أو ٨٥٠) سنة ، لأن الفترة الزمنية التي بين الشيخ الدربندي والسيد المرتضى هي ما ذكرناه ، ولعل العبارة فيها حذف. والله العالم ـ المؤلف.
بمعاتبات كثيرة على فعله هذا ، وأمره بحضوره في الحرم ، فقال للسيد : يا نقيب الأشراف ، خذ مني أموالاً كثيرة ، وأشياء نفيسة ، ولا تأمرني بحضوري في الحرم الشريف ؛ فإغتاظ السيد من كلامه هذا ، لما كان في السيد من الشيمة والنفس الأبية ، والهمة العالية ، فألجأه السيد إلى الحضور في الحرم الشريف ، فحينئذ قام واغتسل ولبس أطيب ثيابه ، وأنظف ملبوساته ، فخرج من الدار ومشى حافياً بالسكينة والوقار ، والخضوع والخشوع ، وجريان الدموع ، إلى أن بلغ باب الصحن الشريف ، فلما وصل إليه ؛ خَرّ لله تعالى ساجداً وقَبّل الأرض ، فلما قام من سجوده ؛ كان يرتعد ويرتعش مثل فرخة العصفور المبلولة ، وقد تغير لونه وإصفرّ وجهه ، وصار كأنه قد نزع الروح من ثلث بدنه ، ثم أنه لما وصل إلى باب مخلع النعال ؛ فعل فيه ما قد فعل في الباب الأول ، ولكنه كان في حالة تشبه حالة النزع والإحتضار ، ثم لما صعد الإيوان ومشى حتى وصل إلى باب الرِّواق ، ونظر إلى القبر الشريف ؛ تنفّس الصعداء ، وتأوّه مثل تأوّه الثكلى ، وقال : أهذا مضجع سيد الشهداء؟! ، أهذ مقتل سيد الشهداء!؟ ثم صاح صيحة كان فيها آخر نفسه (ره) ...»(٥٢١) .
٤ ـ أهداف المجاورة :
إهتمت الشرائع الإلهية ، وخصوصاً الشريعة الإسلامية بتكميل الروح الإنسانية ؛ باستكمالها تدرك الحياة الأبدية ، وإنّ تشريع العبادات والعمل بها من أهم طرق تكميل الروح ، ومن الأشياء التي تستفيد منها الروح مجاورة الإنسان حياً لأولئك العظماء من الأنبياء والأوصياء ، ومن خلال ما ذكر سابقاً ؛ نخرج بالأهداف التالية :
__________________
(٥٢١) ـ الدربندي ، الشيخ آغا بن عابد الشيرواني : إكسير العبادات في أسرار الشهادات ، ج ١ / ٤٦٢ ـ ٤٦٣.
أولاً ـ إنّ مجاورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام تترتب عليها فوائد كثيرة
أهمها ما يلي :
قال السبكي : «الرحمات والبركات النازلة بذلك المحل يعم فَيْضُها الأمة ، وهي غير متناهية ؛ لدوام ترقياته عليه الصلاة والسلام ، وما تناله الأمة بسبب نبيها هو الغاية في الفضل ، ولذا كانت خير أمةٍ بسبب كون نبيها هو خير الأنبياء ، فكيف لا يكون القبر الشريف أفضل البقاع ، مع كونه منبع فيض الخيرات؟ ـ إلى أن قال ـ : فزيارته والمجاورة عنده من أفضل القربات ، عنده تجاب الدعوات ، وتحصل الطلبات ، فقد جعله الله تعالى سبباً في ذلك أيضاً ، فهو روضة من رياض الجنة ، بل أفضل رياضها ، وقد قال (صلى الله عليه وآله وسلّم) : (لَقَابُ قَوْس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها) ، بل لو تعلق بما قررناه من ون القبر الشريف منبع جميع الخيرات ـ وهو بالمدينة ـ ؛ فتكون هي أفضل لكان له وجه»(٥٢٢) .
وقال السمهودي ـ في سرد خصائصها ـ : «كثرة المساجد والمشاهد والآثار بها ، بل البركة عامة منبثة بها ، ولهذا قيل لمالك : أيما أحب إليك المقام ـ هنا ـ ؛ يعني المدينة أو بمكة؟ فقال ههنا ، وكيف لا أختار المدينة وما بها طريق إلا سلك عليها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) ، وجبريل (عليه السلام) ينزل من عند رب العالمين في أقل من ساعة؟»(٥٢٣) .
وبعد هذا ، يمكن القول : إنّ الهدف الذي ذكره بعض علماء العامة ، في فضل سكنى ومجاورة المدينة المنورة ، من كونها منبع فيض الخيرات ، ومحل
__________________
(٥٢٢) ـ السمهودي ، نور الدين علي بن أحمد : وفاء الوفاء ، ج ١ / ٣١.
(٥٢٣) ـ نفس المصدر / ٨٢.
إجابة الدعوات ، وقضاء الحاجات ، وتبركاً بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، هو بعينه هدف الشيعة الإمامية ، من سكنى ومجاورة الأماكن المقدسة ، كالنجف الأشرف ، والكوفة ، وكربلاء ، ونحوها من البقاع التي ضمت أبناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والذين جعلهم الله سبحانه بعد الموت كما كانوا أيام حياتهم ، لقوله تعالى : ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ) [النور / ٣٦]. كيف لا نعتقد بمن حث الله سبحانه في كتابه الكريم على مودتهم واتباعهم ، ويكفينا شاهد على ذلك آية المباهلة ؛ وهي قوله تعالى : ( فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ) [آل عمران / ٦١]. من تأمل في هذه الأية الشريفة ، ونظر إليها بنظرة علمية منصفة ؛ عرف سرّ ما يعتقد به الإمامية في أهل البيت عليهم السلام ، وقد أشار إلى ذلك السيد شرف الدين (قده) ، وخلاصته فيما يلي :
«أجمع أهل القبلة حتى الخوارج منهم ، على أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدع للمباهلة من النساء ، سوى بضعته الزهراء ، ومن الأبناء سوى سبطيه وريحانتيه من الدنيا ، ومن الأنفس إلا أخاه الذي كانه منه بمنزلة هارون من موسى ، فهؤلاء أصحاب هذه الآية ، ولم يشاركهم فيها أحد من العالمين ، كما بديهي لكل من ألمّ بتاريخ المسلمين ، فباهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهم خصومه من أهل نجران ، وقد ذكر ذلك الرازي في تفسيره : «خرج صلى الله عليه وآله وسلم عليه مرط من شعر أسود ، وقد إحتضن الحسين وأخذ بيد الحسن ، وفاطمة تمشي خلفه ، وعلي خلفها ، وهو يقول : إذا أنا دعوت ؛ فأمّنوا. فقال أسقف نجران : يا معشر النصارى ، إني لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيلوا جبلاً لأزاله بها ، فلا تباهلوهم فتهلكوا ، ولا
يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة»(٥٢٤) . بخ بخ إنّ من وقف على الوهلة العظيمة ، والروعة الشديدة التي رهقت أعلام نجران ، وممثلي دينها ودنياها ، بمجرد أن برز أصحاب الكساء لمباهلتهم ؛ عُلِمَ لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم ، جلالة ربانية تغشى الأبصار ، ومهابة روحانية لها جناح الذل والصغار ، ألا ترى أولئك الأبطال ـ وهم ستون فارساً ـ من أسود الشرى ، وليوث الوغى ، كيف ارتعدت فرائصهم قلقاً ، وإنخلعت قلوبهم فرقاً ، ونادى عظيمهم بما سمعت ، وهلوعاً جزوعاً ، وهذا ليس إلا للجلالة الربانية ، والعظمة الروحانية ، التي أدركها خصمهم من أول نظرة إلى وجوههم المباركة ، فكأنّ الجلالة والعظمة ، والمهابة والأبهة ، وقرب المنزلة من الله ، والكرامة عليه مكتوبة بنوره تعالى في أسارير جبهاتهم الميمونة ، ومعنونة في صفحات وجناتهم الكريمة ، وإني لأعجب والله من المسلم لا يقدر هذا المقام وقدره ، وأنت تعلم أنّ مباهلته صلى الله عليه وآله وسلم بهم وإلتماسه منهم التأمين على دعائه بمجرده فضل عظيم ، وانتخابه إياهم لهذه المهمة العظيمة واختصاصه بهذا الشأن الكبير ، وايثارهم فيه على من سواهم من السوابق ، فضل على فضل لم يسبقهم إليه سابق ، ولن يلحقهم فيه لاحق ، ونزول القرآن العزيز آمراً بالمباهلة بهم بالخصوص فضل ثالث ، يزيد فضل المباهلة ظهوراً ، ويضيف إلى شرف إختصاصهم بها شرفاً وإلى نوره نورا. وهناك نكته يعرف كنهها علماء البلاغة ، ويقدر قدرها الراسخون في العلم ، العرافون بأسرار القرآن ، وهي أنّ الآية الكريمة ظاهرة في عموم الأبناء والنساء والأنفس ، وكما يشهد به علماء البيان ، ولا يجهله أحد ممن عرف أنّ الجمع المضاف حقيقة في الإستغراق ، وإنما أطلقت
__________________
(٥٢٤) ـ الفخر الرازي ، فخر الدين ، محمد بن عمر : التفسير الكبير ، مج ٤ ـ ج ٨ / ٨٨ ـ ٨٩.
هذه العمومات عليهم بالخصوص ، تبياناً لكونهم ممثلي الإسلام ، وإعلاناً لكونهم أكمل الأنام وبرهاناً على أنهم خيرة الخيرة ، وتنبيهاً إلى أن فيهم من الروحانية الإسلامية والإخلاص لله في العبودية ، ما ليس في جميع البرية ، وأنّ دعوتهم إلى المباهلة بحكم دعوة الجميع ، وحضورهم خاصة فيها منزّل منزلة حضور الأمة عامة ، وتأمينهم على دعائه مغنٍ عن تأمين مَن عداهم ، وبهذا حاز التجوز بإطلاق تلك العمومات عليهم بالخصوص ، ومن غاص على أسرار الكتاب الحكيم ، وتدبره ووقف على أغراضه ؛ يعلم أنّ إطلاق هذه العمومات عليهم بالخصوص ، وإنما هو على حد قول القائل :
ليس على الله بمستنكر |
أن يجمع العالم في واحد |
ولذا قال الزمخشري في تفسير الآية : «وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء عليهم السلام»(٥٢٥) ...»(٥٢٦) نعم هذه عقيدة الشيعة الإمامية في أهل البيت عليهم السلام ، وقد أوضحها الإمام الهادي عليه السلام في الزيارة الجامعة بقوله : (آخذ بقولكم ، عامل بأمركم ، مستجير بكم ، زائر لكم ، لائِذٌ عائذ بقبوركم ، مستشفع إلى الله عَزّ وجَلّ بكم ، ومتقرب بكم إليه ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي ، وإرادتي في كل أحوالي وأموري).
ثانياً ـ رجاء الفوز بالنعيم والنجاة من عذاب البرزخ ، وهذا الهدف له جهة رجحان في الشرائع الإلهية ، خصوصاً في مثل هذه الحالة التي إنقطعت منها العلاقات ، وبقية التوسلات إلى المقربين لدى خالق البريات ؛ ولذا فالشيعة الإمامية تحرص على الدفن بجوار أمير المؤمنين علي عليه السلام ،
__________________
(٥٢٥) ـ الزمخشري ، جار الله محمود بن عمر : الكَشّاف ، ج ١ / ٤٣٤.
(٥٢٦) ـ شرف الدين ، السيد عبد الحسين : الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء / ٥ ـ ٨.
وأبنائه الطاهرين عليهم السلام ، حيث الفوز بالثواب أو النجات من العقاب ، بل هذه سيرة أعلامهم إلى هذا العصر.
قال السيد بحر العلوم (قده) :
والنبش محظور وحدّه البلا |
وهو لقحّ آدمي جلّلا |
|
والأقرب الجواز للنقل إلى |
جوار من بقربهم نيل العلا(٥٢٧) |
وقال الشيخ الكفعمي (قده) :
سألتكم بالله أن تدفنوني |
إذا مت في قبر بأرض عقير |
|
فإنّي به جار الشهيد بكربلاء |
سليل رسول الله خير مجير |
|
فإنّي به في حفرتي غير خائف |
بلا مرية من منكر ونكير |
|
آمنت به في موقفي وقيامتي |
إذا ال ناس خافوا من لظى وسعير |
|
فإنّي رأيت العرب يحمي نزيلها |
ويمنعه من أن ينال بضير |
|
فإنّي بسبط المصطفى أن يدود مَن |
بحائره ثاوٍ بغير نصير |
|
وعارٌ على حامي الحمى وهو في الحمى |
إذا ضَلّ في ال بيداء عقال بعير(٥٢٨) |
ثالثاً ـ رعاية الأفضل في الدفن ، وقد ذكر ذلك السيد اليزدي (قده) : «بل لا يبعد إستحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر ؛ لبعض المرجحات الشرعية»(٥٢٩) . وعَلّقَ على ذلك السيد السبزواري (قده) بقوله : «لأنّ الحالة حالة يطلب فيها الأفضل فالأفضل مهما أمكن ، وفي النبوي : (إنّ موسى بن عمران لما حضرته الوفاة ، سأل ربّه أن يدنيه إلى الأرض
__________________
(٥٢٧) ـ بحر العلوم ، السيد محمد مهدي : الدرّة النجفية / ٨٣.
(٥٢٨) ـ الحكمي ، الشيخ محمد رضا : تاريخ العلماء عبر العصور / ٢٤.
(٥٢٩) ـ اليزدي ، السيد محمد كاظم الطباطبائي : العروة الوثقى / ١٥٠.
المقدسة رمية حجر). وقال (صلى الله عليه وآله) : (لو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر).
ومن المرجحات الشرعية تعدد الإمام المدفون فيها ، كما في البقيع. ومنها : كثرة الشهداء ، وهذا يختص بالمدينة المنورة ، وكربلاء المقدسة»(٥٣٠) .
رابعاً ـ ما ورد في شراء بعض الأئمة للبقاع التي دفنوا فيها ، والترغيب والحث على فضلها وقداستها ، كما في الروايات التالية :
١ ـ السيد عبد الكريم بن أحمد بن طاوس في (فرحة الغري) قال : روى أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن عبد الرحمان العلوي الحسني في (كتاب فضل الكوفة) ، بإسناده إلى عقبة بن علقمة قال : (اشترى أمير المؤمنين عليه السلام أرضاً ما بين الخورنق إلى الحيرة إلى الكوفة). وفي خبر آخر : (ما بين النجف إلى الحيرة إلى الكوفة من الدّهاقين بأربعين ألف درهم ، وأشهد على شرائه ، قال : فقلت له : يا أمير المؤمنين تشتري هذا بهذا المال وليس ينبت خطا؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : كوفان كوفان يرد أولها على آخرها ، يحشر من ظهرها سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ، فإشتهيت أن يحشروا من ملكي)(٥٣١) .
٢ ـ الشيخ البهائي في الكشكول : عن خط جده محمد بن علي الجباعي ، نقلاً من خط ابن طاووس ، نقلاً من كتاب الزيارات لمحمد بن أحمد بن داود القمي ، عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال : (إنّ حرم الحسين (عليه
__________________
(٥٣٠) ـ السبزواري ، السيد عبد الأعلى الموسوي : مهذب الأحكام ، ج ٤ / ٢٣٧.
(٥٣١) ـ الحر العاملي ، الشيخ محمد بن الحسن : وسائل الشيعة ، ج ٢ / ٨٣٣ ، (الباب ١٢ من أبواب الدفن ـ الحديث ١).
السلام) الذي إشتراه ، أربعة أميال في أربعة أميال ، فهو حلال لولده ومواليه ، حرام على غيرهم ممن خالفهم ، وفيه البركة)(٥٣٢) .
وبعد ذكر هاتين الروايتين ؛ نخرج بالنتيجة التالية :
أولها ـ إنّ شراء الأئمة عليهم السلام لهذه البقاع لمواراة أجسادهم فيها ؛ دليل على إختيار الأفضل ، ووجود مزية شرف وقداسة فيها على غيرها.
ثانيها ـ لو تأملنا في عبارة أمير المؤمنين عليه السلام : (فاشتهيت أن يحشروا من ملكي) ، بعد بيان فضل تلك البقعة التي إشتراها ، من أنّه يحشر من ظهرها سبعون ألفاً ، يدخلون الجنة بغير حساب ؛ لظهر لنا حث الموالين له على إغتنام فرصة الدفن فيها لنيل تلك الفضيلة. وكذلك المستفاد من عبارة الإمام الصادق عليه السلام : (فهو حلال لولده ومواليه) ، بعد بيان أنّ هذه البقعة التي إشتراها سيد الشهداء عليه السلام هي حرم ، فهذا برهان واضح على أنّ من دفن في هذا الحرم ، فهو في أمان مما يخاف ويحذر من أهوال القبر ، بل من السعداء الآمنين من أهوال الآخرة بشفاعته عليه السلام.
خامساً ـ إنّ دفن الميت في هذه البقاع الطاهرة الشريفة أو النقل إليها ، من باب التكريم له ؛ لتستفيد روحه من بركاته ، فإذا وصلت جنازته إلى ذلك المكان المبارك ؛ فقد نالت المنى وحازت على المغفرة والثواب ، بل هذا يدل على أنّ الميت عزيزاً عند أهله ، وإلا لما تكلفوا بنقله هذا العناء من مسافات بعيدة ، كما في قضية اليماني المعروف بـ(صافي الصفا) ، وقبره يقع في الجانب الغربي من النجف ، عند حافة التل الذي تقع عليه المدينة ، أو عند حافة الهضبة الصحراوية ، وإلى جواره مقام زين العابدين عليه السلام ،
__________________
(٥٣٢) ـ النوري ، الميرز حسين الطبرسي : مستدرك الوسائل ، ج ١٠ / ٣٢١ ، (الباب ٥٠ من أبواب المزار ـ الحديث ٢).
وقبره مشهور ويزار. ولأهمية هذا الرجل المؤمن الذي حظئ وتشرف بعناية أمير المؤمنين عليه السلام ، ينبغي البحث فيما يلي :
أ ـ قصة دفن صافي الصفا في النجف الأشرف :
ذكر الشيخ المجلسي (قده) : «وجدت في بعض مؤلفات أصحابنا : أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان ذات يوم يصلي بالغريّ ، إذ أقبل رجلان معهما تابوت على ناقة فحطّا التابوت ، وأقبلا إليه فسلّما عليه فقال : من اين أقبلتما؟ قالا : من اليمن. قال : وما هذه الجنازة؟ قالا : كان لنا أب شيخ كبير ، فلما أدركته الوفاة أوصى إليه أن نحمله وندفنه في الغري ، فقلنا : يا أبانا ، إنه موضع شاسع بعيد عن بلدنا ، وما الذي تريد بذلك؟ فقال : إنّه سيدفن هناك رجل يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر. فقال أمير المؤمنين عليه السلام : الله أكبر ، الله أكبر ، أنا والله ذلك الرجل ، ثم قام فصلّى عليه ، ودفناه ومضيا من حيث أقبلا»(٥٣٣) .
ب ـ علاقته بأمير المؤمنين (عليه السلام) :
بعد أن ذكرنا قصته المتقدمة ، نتساءل : كيف عرف أنه سيدفن في النجف رجل يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر؟ هل كان هذا معروفاً في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمعه؟ هل له علاقة بأمير المؤمنين عليه السلام يوم كان مرسلاً من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن؟ كل هذه التساؤلات تحتاج إلى جواب :
والجواب يتضح من خلال ما يلي:
أولاً ـ لا مانع من القول بأنّه سمع ذلك في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؛ حيث تذكر بعض الروايات ذهاب علي عليه السلام إلى اليمن كما في الرواية التالية :
__________________
(٥٣٣) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الانوار ، ج ٤٢ / ٣٣٣ ـ ٣٣٤.
عن البراء بن عازب قال : (بعث رسول الله (صلى الله عليه (وآله) وسلم) خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام ، وكنت فيمن سار معهم ، فأقام عليهم ستة أشهر لا يجيبونه إلى شيء ، فبعث النبي ـ صلى الله عليه (وآله) وسلّم) ـ إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام) ، وأمره أن يرسل خالداً ومن معه إلا من أراد البقاء مع علي (عليه السلام) فيتركه ، قال البراء : وكنت فيمن عقب مع علي (عليه السلام) ، فلما إنتهينا إلى أوائل اليمن ؛ بلغ الخبر فجمعوا له فصلى بنا الفجر ، فلما فرغ صَفّاً صَفّاً واحداً ثم تقدم بين أيدينا ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قرأ عليهم كتاب رسول الله (صلى الله عليه (وآله) وسلّم) ، فأسلمت همدان كلها في يوم واحد ، وكتب بذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه (وآله) وسلّم) ، فلما قرأ كتابه ، خَرّ ساجداً وقال : السلام على همدان ، السلام على همدان(٥٣٤) . وهذا النصر الذي تحقق على يد أمير المؤمنين عليه السلام بإسلام هذه القبيلة بهذه السرعة ، جعل هذه القبيلة تسأل عن هذه الشخصية العظيمة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فلما سمعت بفضله تمسكت بولائه ، وخير شاهد على ذلك ، ما عرف عن هذه القبيلة من تمسكها بولاء علي عليه السلام ، ومدحه لها بقوله المنسوب إليه :
ولو أنّ يوماً كنتُ بَوّاب جَنّةٍ |
لقلت لهمدان ادخلوا بسلام(٥٣٥) |
وبعد هذا ثبت لنا علاقة علي عليه السلام باليمن ـ خصوصاً همدان ـ ، ولعلّ (صافي الصفا) من هذه القبيلة.
__________________
(٥٣٤) ـ الطبري ، الحافظ محب الدين أحمد بن عبد الله : ذخائر العقبى / ١٠٩ ـ ١١٠.
(٥٣٥) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٣٨ / ٧١.
ثانياً ـ لعلّ (صافي الصفا) هو اليماني صاحب الدعاء المعروف (بدعاء اليماني) ، الذي ذكره ابن طاووس بإسناده عن ابن عباس ، وعبد الله بن جعفر : (بينما نحن عند مولانا أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب (صلوات الله عليه) ذات يوم ؛ إذ دخل الحسن بن علي (عليهما السلام) فقال : يا أمير المؤمنين بالباب رجل يستأذن عليك ينفخ منه رائحة المسك : قال له : إئذن له. فدخل رجل جسيم وسيم له منظر رائع ، وطرف فاضل ، فصيح اللسان ، عليه لباس الملوك ، فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ، ورحمة الله وبركاته ، إني رجل من أقصى بلاد اليمن ، ومن أشراف العرب ، وممن ينتسب إليك ، وقد خَلّفت ورائي ملكاً عظيماً ، ونعمة سابغة ، وإني لفي غضارة من العيش وخفض من الحال ، وضياع ناشئة ، وقد عجمت الأمور ، ودَرّبتني الدهور ، ولي عدو مشجّ ، وقد أرهقني وغلبني بكثرة نفيره ، وقوة نصيره ، وتكاتف جمعه ، وقد أعيتني فيه الحِيَل ، وإني كنت راقداً ذات ليلة حتى أتاني آتٍ فهتف بي : أن قم يا رجل إلى خير خلق الله بعد نبيه ، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (صلوات الله عليه وعلى آله) ، فاسأله أنّ يعلمك الدعاء الذي علمه حبيب الله ، وخيرته وصفوته من خلقه ، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب (صلوات الله عليه وآله) ، فاسأله أنّ يعلمك الدعاء الذي علمه حبيب الله ، وخيرته وصفوته من خلقه ، محمد بن علد الله بن عبد المطلب (صلوات الله عليه وآله) ، ففيه اسم الله عَزّ وجَلّ ، فادع به على عدوك المناصب لك ، فانتبهت يا أمير المؤمنين ، ولم أعوج على شيء حتى ضخصت نحوك في أربع مائة عبد ، إني اُشهد الله واُشهد رسوله ، واُشهد أنهم أحرار ، قد أعتقتهم لوجه الله جَلّت عظمته ، وقد جئتك يا أمير المؤمنين من فَجّ عميق وبلد شاسع ، قد ضؤل جرمي ونحل جسمي ، فأمنن عليّ يا أمير المؤمنين بفضلك ، وبحق الأبوة والرحم الماسّة ، علمني الدعاء
الذي رأيت في منامي ، وهتف بي أن أرحل فيه إليك ، فقال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) : نعم أفعل ذلك إن شاء الله ، ودعا بدواة وقرطاس وكتب هذا الدعاء قال ابن عباس (رضي الله عنه) : ثم قال له : إنظر إن حفظ لك ولابد عن قراءته يوماً واحداً ، فإني أرجوا أن توافي بلدك وقد أهلك عدوك ، فإني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول : (لو أن رجلاً قرأ هذا الدعاء بنيِّة صادقة ، وقلب خاشع ، ثم أمر الجبال أن تسير معه لسارت ، وعلى البحر لمشى عليه). وخرج الرجل إلى بلاده ، فورد كتابه على مولانا أمير المؤمنين (صلوات الله عليه وآله وسلم) بعد أربعين يوماً ، أنّ الله قد أهلك عدوه ، حتى أنه لم يبق في ناحيته رجل ، فقال مولانا رسول الله (صلوات الله عليه وآله وسلم) ، وما إستعسر عليّ أمر إلا استيسر به»(٥٣٦) .
وبعد معرفة هذه التفاصيل ، ليس من المستبعد أن يكون هذا الرجل هو صافي الصفا ، ومن الأمور التي تقوي هذا الإحتمال ، ما ذكرته القصة من قوة تمسكه بأمير المؤمنين عليه السلام ، فلا غرابة أن نحتمل أنّ مثل هذه الشخصية الولائية أن توصي بالدفن بجوار أمير المؤمنين عليه السلام ، مع هذا العناء لأولاده وبُعد المسافة من اليمن إلى النجف الأشرف ، إنّ مثل هذه الأوصاف من أقرب مصاديقها ، هو صافي الصفا ، الذي ما زال ذكره خالداً إلى هذا اليوم ، بزيارة قبره المستمر من قِبَل زوار وضيوف أمير المؤمنين عليه السلام.
ثالثاً ـ «قال بعض علماء الأهواز : إنّ اليماني هذا كان من أصحاب الزاهد العابد أويس القرني ، وحَدّث آخرون أنه من تلامذته الذين تخرجوا عليه في العلم
__________________
(٥٣٦) ـ ابن طاووس ، السيد رضي الدين علي بن موسى : مهد الدعوات / ١٦٠ ـ ١٦٧.
والزهد والعبادة ، لعلي بن أبي طلب أمير المؤمنين (عليه السلام)»(٥٣٧) . وسمي بـ(صافي الصفا) ؛ لأنه كانت الدراويش تسكنه وتسمي حرم قبره بالصفة ، فإذا أضافوها يقولون : صفة الصفا ، ويبدو أنّ هذا الإشتهار كان في حدود القرن السادس للهجرة وإلى زماننا ، والصفا هو الصخر ؛ أي مقبرة الصخر ؛ حيث أنها تقع على رأس الوادي وصخوره البارزة ، وقد أدركنا بقية رأس الوادي وبعض صخوره الظاهرة ، ومنه مجرى مياه الأمطار التي تسيل من رأس الوادي ، قرب الصحن الغروي الأقدس ، في أواخر القرن الثالث عشر الهجري(٥٣٨) .
نتيجة البحث :
وبعد عرض هذه التفاصيل المتعلقة بمسألة المجاورة ؛ تبين لنا إتفاق المذاهب الإسلامية الخمسة ، بل العقلاء على جواز النقل إلى البقاع المقدسة ، بل هذا ثابت في الشرائع السماوية ، وقد تعرضت الكتب التاريخية إلى ذلك ، ومن أراد التوسع ؛ فليراجع ما كتبه العلامة الكبير الشيخ الأميني (قده) في موسوعة الغدير ، ج ٥ / ٦٦ ـ ٨٥.
__________________
(٥٣٧) ـ حرز الدين ، الشيخ محمد : مراقد المعارف ، ج ٢ / ٣٨٦.
(٥٣٨) ـ نفس المصدر ، ج ٢ / ٣٨٢ ـ ٣٨٣.
نتائج
تساؤلات البحث
بعد إنهاء هذا البحث ؛ نأتي إلى نتائجه ، المتمثلة في الإجابة على التساؤلات التي ذكرت في بدايته.
وقلنا في بداية البحث : لعلّ من أهم التساؤلات في هذا البحث هو التالي :
ذكرت الروايات أسماء عديدة للتربة الحسينية ـ على مُشرِّفها آلاف التحية والسلام ـ ، فما الهدف من ذلك؟
والجواب على هذا التساؤل ، يستدعي البحث فيما يلي :
إنّ الإسلام أطلق أسماء خاصة ـ من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية ـ على الأشياء المحترمة لديه ، على أنّ الإعتبار في استعمال هذه الأسماء إنما هو لهدف ، ولعلّ من أهم الأهداف ما يلي :
أولاً ـ إيجاد شعار خاص للدين الإسلامي يتميز به عن غيره من الديانات السابقة ، وهذا ما نراه واضحاً في قوله تعالى : ( وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَـٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ) [الحج / ٧٨].
قال الشيخ الطوسي (قده) : «وقوله تعالى : ( هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ ) ، قال ابن عباس ومجاهد : الله سماكم المسلمين فهو كناية عن الله. وقال ابن زيد : هو كناية عن إبراهيم وتقديره إبراهيم سماكم المسلمين ، بدليل قوله : ( وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ) [البقرة / ١٢٨]»(٥٣٩) . وأيضا يستفاد من الآية ما يلي :
__________________
(٥٣٩) ـ الطوسي ، الشيخ محمد بن الحسن : التبيان في تفسير القرآن ، ج ٧ / ٣٤٤ ـ ٣٤٥.
١ ـ إنّ الإسلام درجات ، أعلاها ما كان عليه إبراهيم عليه السلام ، وأدناها ما عليه عامة المسلمين ، يحفظون بها دمائهم وأموالهم ، مع ما عليه بعضهم من لفسق والشقاء ، وقد جمع جملة من مراتبها نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المعروف : (المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه)(٥٤٠) .
٢ ـ روي : أنّ الله أعطى هذه الأمة ثلاثة أشياء لم يعطها أحداً من الأمم ؛ جعلها الله شهيداً على الأمم الماضية ، وقال لهم : ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) [الحج / ٧٨]. وقال : ( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) [غافر / ٦٠](٥٤١) . وبعد هذا البيان نقول : إنّ النهضة الحسينية المباركة التي أخبر بها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأكد عليها ، وما تركته من آثار إيجابية للحفاظ على الإسلام بعد أن كاد أن يدرس ؛ حيث أنّ نهضته المباركة أظهرت الإسلام الحقيقي الذي جاء به جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ، وكشفت الإسلام المزيّف الذي تقنّع به أعداء أهل البيت النبوي ، وهذا ما أكد عليه بقوله : (وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمّة جَدّي ، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام ، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ، وهو خير الحاكمين)(٥٤٢) . إذن هذا يؤكد مدى مقامه العالي ، ومنزلته عند الله عَزّ وجَلّ ، وهذا ما نجده في بعض أسماء أرض مصرعه مثل : (قبة الإسلام ، وأرض الله المقدسة ، وروضة من رياض الجنة ،
__________________
(٥٤٠) ـ السبزواري ، السيد عبد الأعلى : مواهب الرحمن في تفسير القرآن ، ج ٢ / ٤٠ ـ ٤١. (بتصرف)
(٥٤١) ـ الطوسي ، الشيخ محمد بن الحسن : التبيان في تفسير القرآن ، ج ٧ / ٣٤٥. (بتصرف)
(٥٤٢) ـ موسوعة كلمات الحسين (ع) / ٢٩١ ، إعداد لجنة الحديث (معهد تحقيقات باقر العلوم).
وترعة من ترع الجنة ، وبطحاء الجنة ونحو ذلك ، وعلى هذا فالحسين عليه السلام وما قَدّمَه من تضحيات ، هو شعار للإسلام عرف بين المسلمين وغيرهم.
ثانياً ـ تربية الأمة الإسلامية بطابع خاص تتميز به عن غيرها من الأمم ، عن طريق هذه الأسماء والمصطلحات فعلى سبيل المثال : قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا ) [البقرة / ١٠٤].
وخلاصة ما ذهب إليه المفسرون في هذه الآية الشريفة ما يلي :
روي أنّ المسلمين كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ألقى عليهم شيئاً من العلم (راعنا) ، وكانت لليهود كلمة عبرانية يتسابون بها وهي (راعنا) ، إفترصوا ذلك وخاطبوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، ولما سمعها سعد بن معاذ منهم ، وكان يعرف العبرية ـ قال : يا أعداء الله عليكم لعنة الله ، والذي نفسي بيده لئن سمعتها من رجل منكم يقولها لرسول الله لأضربنّ عنقه. فقالوا ألستم تقولونها؟ فنزلت الآية.
وما تحويل القبلة ، وتعيين أعياد خاصة للمسلمين ، وتسمية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من لم يتبع الإسلام (جاهلي) إلا مؤيداً لما ذكرناه ، من الحرص على إيجاد أمة مستقلة مميزة على سائر الأمم الغارقة في الخرافة والجهل ، مستقلة في الفكر والسلوك والعواطف والمشاعر ، هكذا أرادها الله وصنعها رسوله الكريم ، خير أمة أخرجت للناس. وقد سار على هذا النهج وأحياه حسين التاريخ ، الذي أصبح مثالاً أعلى لرجال الإصلاح ، ولا عجب إن عدت نهضته المباركة المثل الأعلى ، وحازت شهرة وأهمية عظيمة لما قام به من تفادي لدين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأمته ؛ إذ قام بتضحية أوضحت النفوس الأموية ،
ومكائدها وسوء نواياها في نبي الإسلام ودينه ، وقد أعلن بذلك يزيدهم طغياناً ـ وهو على مائدة الخمر ـ متمثلاً بقول ابن الزّبَعُرى :
ليت أشياخي ببدر شهدوا |
جزع الخزرج من وقع الأسل |
|
لعبت هاشم بالملك فلا |
خبر جاء ولا وحي نزل |
|
لست من خندف إن لم أنتقم |
من بني أحمد ما كان فعل(٥٤٣) |
وقد تحدث الإمام السجاد عليه السلام بفضح الأمويين قائلاً : (ولقد كان جَدّي علي بن أبي طالب في يوم بدر ، وأحد ، والأحزاب ، في يده راية رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، وأبوك وجدك في أيديهم رايات الكفار)(٥٤٤) .
نعم في قضية الحسين عليه السلام حجج بالغة برهنت على أنهم يقصدون التشفي منه والإنتقام ، وأخذهم ثارات بدر وأحقادها.
إنّ الذي جرى في يوم عاشوراء على الحسين عليه السلام ، وأهل بيته وصحبه من المصائب والمحن ؛ عَبّرَت عنه زيارة عاشوراء بـ : (لقد عظمت الرزية ، وجلّت المصيبة بك علينا ، وعلى جميع أهل الإسلام ، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام ، وفي جميع السماوات والأرض)(٥٤٥) .
إنّ هذه المظلومية صارت من الألقاب التي يقترن بها إسمه على الدوام ، وغالباً ما تذكر عبارة (يا حسين يا مظلوم في الزيارات والأحاديث ، والتركيز على هذا اللقب ، يستهدف بيان ظلم الأمويين ومن سار على نهجهم للحسين وأهل بيته الكرام ، بل صار علماً لبقعته الطاهرة (كرب وبلاء) ، وقد أشار إلى ذلك
__________________
(٥٤٣) ـ موسوعة كلمات الحسين (ع) / ٢٩١ ، إعداد لجنة الحديث (معهد تحقيقات باقر العلوم).
(٥٤٤) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٤٥ / ١٣٦.
(٤٥٤) ـ نفس المصدر ، ج ٩٨ / ٢٩٤.
أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : (وهذه أرض كرب وبلاء ، يدفن فيها الحسين عليه السلام وسبعة عشر رجلاً من ولدي وولد فاطمة ، وإنها لفي السماوات معروفة ، تذكر : أرض كرب وبلاء ، كما تذكر بقعة الحرمين ، وبقعة بيت المقدس)(٥٤٦) .
إذا إعتبرنا (كربلاء) أرض البلاء ؛ فهي موضع إختيار لإخلاص سيد الشهداء وأهل بيته وصحبه للعقيدة والدين ، وقد تجلى جوهرهم الذاتي وبعدهم الرفيع ، ومدى صدق عقيدتهم ، وقد أشار إلى ذلك سيد الشهداء بقوله : (الناس عبيد الدنيا ، والدين لعق على ألسنتهم ، يحوطونه ما دَرّت معايشهم ، فإذا محِّصوا بالبلاء قلّ الديّانون)(٥٤٧) . وشهد لأهل بيته وصحبه بقوله : (أما بعد ـ فإني لا أعلم أصحاباً أصلح منكم ، ولا أعلم أهل بيت أبرّ ولا أوصل ولا افضل من أهل بيتي ، فجزاكم الله جميعاً عني خيراً)(٥٤٨) .
إضافة إلى ما تضمنته كربلاء من إمتحان عظيم ، فقد كانت في الوقت نفسه سبباً للتقرب إلى الله وعلو الدرجة ، حيث قدّم سيد الشهداء إثنين وسبعين قرباناً ، وهو الذبح العظيم وقربان إلى الله ، وتعرض عياله في صحراء كربلاء لصنوف الأذى والعذاب. وبعد هذا البيان ، إتضح لنا أن واقعة الطف كانت من أعظم الحوادث في تاريخ البشرية ، والتي عَرّفت المسلمين وغيرهم على القيم النبيلة ، ومفهوم الحياة الهادف ، ومن الشواهد على ذلك ما يلي :
__________________
(٥٤٦) ـ المصدر السابق ، ج ٤٤ / ٢٥٣.
(٥٤٧) ـ الخوارزمي ، أبي المؤيد الموفق بن أحمد المالكي : مقتل الحسين ، ج ١ / ٣٣٧.
(٥٤٨) ـ نفس المصدر / ٣٤٩ ـ ٣٥٠.
لياقة علي خان(٥٤٩) ـ أول رئيس وزراء باكستاني ـ قال : «لهذا اليوم من محرم مغزىً عميقاً لدى المسلمين في جميع أرجاء العالم ، ففي مثل هذا اليوم وقعت واحدة أكثر الحوادث أسىً وحزناً في تاريخ الإسلام ، وكانت شهادة الإمام الحسين (عليه السلام) مع ما فيها من الحزن مؤشر ظفر نهائي للروح الإسلامية الحقيقية ؛ لأنّها بمثابة التسليم الكامل للإرادة الإلهية ، ويتعلم منها وجوب عدم الخوف والإنحراف عن طريق الحق والعدالة ، مهما كان حجم المشاكل والأخطار»(٥٥٠) .
تاملاس توندون ، الهندوسي والرئيس السابق للمؤتمر الوطني الهندي : «هذه التضحيات الكبرى من قبيل شهادة الإمام الحسين عليه السلام ، رفعت من مستوى الفكر البشري ، وخليق بهذه الذكرى أن تبقى إلى الأبد ، وتذكر على الدوام»(٥٥١) . وخلاصة ما توصلنا إليه : إنّ نهضة الحسين عليه السلام صارت مدرسة للأجيال ، تعطي دروساً عملية للإنسانية على مر العصور ، هذه الدروس التي يمكن استخلاصها من عاشوراء كامنة في أقوال الحسين عليه السلام وأنصاره ، وفي سلوكهم ومعنوياتهم ، ومدى تأثير تلك الواقعة في فكر وحياة المسلمين ، وخلود تلك الملحمة ومعطياتها على مدى التاريخ ، ومن يتأمل أحداث هذه الواقعة ؛ يتعرف على عبرها ودروسها ، فعلى هذا إستحقت تربة الحسين عليه السلام الإهتمام في الروايات بكثرة تعداد أسمائها ، مشاركة بقية البقاع الإسلامية المقدسة نفس الهدف الإسلامي المقدس.
__________________
(٥٤٩) ـ لياقات علي خان (١٨٩٥ ـ ١٩٥١ م) : سياسي باكستاني ، رافق محمد علي جناح وناضل معه من أجل إنشاء باكستان ، حتى إذا أنشئت الدولة الجديد ، تولى رئاسة الوزارة (١٩٤٧ ـ ١٩٥١ م) ، إغتاله بعض المتعصبين لرفضه فكرة إعلان الحرب على الهند ـ موسوعة المورد العربية ، ج ٢ / ١٠٥٠.
(٥٥٠) ـ محدثي ، جواد : موسوعة عاشوراء / ٢٩٢ ـ ٢٩٣.
(٥٥١) ـ نفس المصدر / ٢٩٤.
معجم الألفاظ
يوجد في هذا الجزء من (التربة الحسينية عليه اسلام دراسة وتحليل) ألفاظ وتعابير ومصطلحات تحتاج إلى تفسير ؛ لذا تسهيلاً للقارئ الكريم ، وضعت هذا المعجم محتوياً على شرحها وتفسيرها بالشكل التالي :
أبو جعفر الثاني عليه السلام :
كنية للإمام الجواد عليه السلام ، تمييزاً له عن الإمام الباقر عليه السلام ؛ إذ هو أبو جعفر أيضاً.
الحـ ـ أ ـ ـ رف
الأبّهَة :
بضم الهمزة وتشديد الباء : العظمة والكبر والبهاء ، ويقال تأبّه الرجل تأبّهاً إذا تكبر. وفي الدعاء : (كم من ذي أبّهة جعلته حقيراً). مجمع البحرين ، ج ٦ / ٣٣٩.
الأخْدُود :
الخَدُّ والأخْدُود : شقّ في الأرض مستطيل غائِصٌ ، وجمع الأخدود أخاديد ، وأصل تلك من خَدّي الإنسان وهما ما اكتنفا الأنف عن اليمين والشمال. والخدُّ يستعار للأرض ولغيرها كاستعارة الوجه. وأصحاب الأخدود : هو أخدود بنجران خَدّه الملك ذو نواس الحميري ، وأحرق فيه نصارى نجران ، وكان على دين اليهود ، فمن لم يرجع عن دين النصارى إلى دين اليهود أحرقه. راجع المفردات للراغب الإصفهاني ، ج ١ / ١٩٠ ، ومجمع البحرين للطريحي ، ج ٣ / ٤٢.
أذْفَر :
الذَفَر بالتحريك : شدّة ذكاء الريح. ومنه مسك أذفر ؛ أي جيد الريح. راجع مجمع البحرين للطريحي ، ج ٣ / ٣٠٩.
أرض السّوَاد :
هي كل أرض عامرة بخضرة الزرع والأشجار ، وإنما أطلق المسلمون هذا الإسم على الأرض العراقية ؛ لأنّهم حين خرجوا من أرضهم القاحلة في جزيرة العرب ، يحملون الدعوة إلى العالم ؛ ظهرت لهم خضرة الزرع والأشجار في أراضي العراق ؛ فَسمّوا خضرة العراق سواداً ؛ لأنّهم كانوا يجمعون بين الخضرة والسواد في الاسم. راجع القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية للشيخ عبد الله الغديري / ٢٠.
الآراميون :
شعب ساميّ سكن في ما بين القرن الحادي عشر والقرن الثامن قبل الميلاد ، منطقة آرام (سوريا الشمالية) ، وبسط سيطرته على سهل البقاع الواقع بين سلسلتي جبال لبنان الشرقية والغربية ، وعلى دمشق أيضاً. وفي هذه الفترة نفسها إستولت بعض القبائل الآرامية على بابل (في العراق). حتى إذا كان القرن التاسع قبل الميلاد أمست المنطقة الممتدة من بابل إلى البحر الأبيض المتوسط خاضعة لسلطان الآراميين. راجع موسوعة المورد العربية للبعلبكي ، ج ١ / ١٠.
إرِيحَاء :
مدينة في فلسطين المحتلة ، تقع على مبعدة ثمانية كيلو مترات إلى الشمال من البحر الميت. وهي مدينة الجبّارين في الغور من أرض الأرْدُن بالشام ، بينها وبين بيت المقدس يوم للفارس في جبال صعبة المسلك ، سميت فيما قيل : بأريحا من مالك ، بن أرفخشد ، بن سام بن نوح عليه السلام. راجع : موسوعة المورد العربية ، للبعلبكي ، ج ١ / ٧٢. ومعجم البلدان ، للحموي ، ج ١ / ١٦٥.
أسود الشُرّى :
الشُرّى : إنثى الشرّ الذي هو الأشرُّ في التقدير ، كالفضلّى الذي هو تأنيث الأفضل ؛ أي تذكر لمفاضلة في الشر. راجع : لسان العرب ، لابن منظور ، ج ٤ / ٤٠٠.
أغْرَارُ تصدوا للدفاع :
الغرارة الغفلة ، حداثة السن ، يقال : (كان ذلك على غرارتي) ؛ أي حداثة سني ، والغِرّ جمع أغرار : الشاب له خبرة له. راجع المنجد في اللغة / ٥٤٦.
الأنْبَار :
آثار مدينة في العراق على الفرات ، فتحها خالد بن الوليد (٦٣٤ م) ، جعلها السفاح عاصمة الدولة العباسية إلى أن تأسست بغداد. وفي الوقت الحاضر محافظة في العراق قاعدتها الرمادي ، لها ٦ أقضية : الرمادي ، القائم ، عَنه ، حدييثه ، هيت ، الفلوجة. راجع المنجد في الأعلام / ٧٣.
الأنْبَاط :
قبائل عربية أنشأت في أراضي المملكة الأردنية الحالية ، مملكة تُعرف بالمملكة النبطية وعاصمتها سَلْع البتراء ، وقد إزدهرت هذه المملكة في الفترة الممتدة من القرن الرابع قبل الميلاد إلى القرن الأول للميلاد. وليس يعرف المؤرخون شيئاً كثيراً عن الأنباط ، ولكن من الثابت لديهم أنّهم مدنيون بازدهار مملكتهم لموقعها على طريق القوافل التجارية الوافدة من بلاد العرب الجنوبية إلى سوريا ، وقد إحتل الأنباط حوران ، وبسطوا سلطانهم بُعَيْد عام ٨٥ قبل الميلاد على دمشق ، وما هي إلا فترة بسيرة حتى أطاح الإمبراطور تراجان بمملكتهم ، واحتل عاصمتها عام ١٠٦ للميلاد. راجع موسوعة المورد العربية للبعلبكي ، ج ١ / ١٣٣.
أصْدَقِ الأسماء :
الصِّدْقُ : الجامع للأوصاف المحمودة ، وكلما نسب إلى الصلاح والخير أضيف إلى الصدق ، كقولهم : (دار صدق) و (غرس صدق) ، فأصدق الأسماء ؛ هي الجامعة للأوصاف المحمودة. راجع : لسان العرب لإبن منظور ، ج ١٠ / ١٩٦.
الأيْفَاع :
اليَفَاع : ما ارتفع من الأرض ، أو ما إرتفع من كل شيء ، والمراد به ـ هنا ـ التلّ المشرف : راجع : مجمع البحرين ، ج ٤ / ٤١٢.
الإيْوَان :
جمع إيوانات وأوَاوِين : المكان المتسع من البيت ، تحيط به ثلاث حيطان ، ويطلق على القصر ، ومنه إيوان كسرى. راجع : المنجد في اللغة / ٢٣.
الحـ ـ ب ـ ـ رف
بَخٍ بَخٍ :
بخ : كلمة تقال عند الرضا والمدح ، مبنية على السكون ، يقال : (بَخْ بَخْ) ، فإن وصلت خففت (بَخٍ بَخٍ) ، وربما شددت. راجع مجمع البحرين ، ج / ٤٢٩.
بُرْنُسَاء :
البُرْنُس : كل ثوب يكون غطاءُ الرأس جزءاً منه متصلاً به ، قلنسوة طويلة كانت تُلبس في صدر الإسلام. راجع : المنجد في الأعلام / ٣٦.
البُرونْز (الصفر) :
خليط من النحاس والقصدير ، يستعمل في صَبّ الأجراس والتماثيل وغيرها. راجع : المنجد في اللغة / ٣٦.
بَرْقَاء :
البُرْقَة والبَرْقَاء والأبرق : غِلظ فيه حجارة ورمل. وبُرَق : ديار العرب تنيف على مائة. راجع : الإفصاح في فقه اللغة ، ج ٢ / ١٠٢٦.
البريد الشرعي :
هو مقدار نصف المسافة الشرعية الموجبة للتقصير ؛ أي هو أربعة فراسخ إجماعاً ونصوصاً. وهو إثنا عشر ميلاً إجماعاً. وهو ثمان وأربعون ألف ذراع بذراع اليد بلا إشكال وقد قدر بما يساوي ٢٢ كم حسب التقديرات المعاصرة. الأوزان المقادير / ص ٢٠.
البوار :
البور : هي الأرض التي لم تزرع : مجمع البحرين ج ٣ / ٢٣١.
بَعْقُوبَا :
ويقال : بَا عَقُوا أيضاً : قرية كبيرة كالمدينة بينها وبين بغداد عشرة فراسخ من أعمال طريق خراسان ، وهي كثيرة الأنهار والبساتين ، واسعة الفواكه متكائفة النخل ، وبها رُطَبٌ وليمون يضرب بحسنها وجودتها المثل ، وهي راكبة على نهر دَيالَى من جانبه الغربي ، ونهر جَلولاء يجري في وسطها ، وعلى جنبي النهر سوقان وعليه قنطرة ، وعلى ظهر القنطرة يتصل بين السُوقَيْن ، والسفن تجري تحت القنطرة إلى باجِسْرَا وغيرها من القرى ، وبها عدة حمامات ومساجد. راجع : معجم البلدان ، ج ١ / ٤٥٣.
بُغَام ناقة علي :
بَغَمْ وبُغَامَاتِ : الناقة قطعت الحنين ولم تمدّه. راجع : المنجد في اللغة / ٤٤.
الحـ ـ ت ـ ـ رف
تنِّمره في ذات الله :
تَنمر : غضب وتغير وأوعد في ذات الله. راجع : المنجد في اللغة / ٨٣٨.
التّنُوخيّون :
تنوخ : قبيلة عربية مسيحية الأصل ، من شعوب مملكة الحيرة في العراق ، إنتقلت إلى بلاد حلب واعتنقت الإسلام على عهد المهدي العباسي ، إستوطنت جماعة منها جبل لبنان ، فخرج منهم الأمراء التنوخيون الذين عرفوا بأمراء الغرب وهم البحتريون. راجع المنجد في الأعلام / ١٩٤.
الحـ ـ ث ـ ـ رف
الثّقَلَين :
قال ثعلب : وأصل الثِّقَل أنّ العرب تقول لكل شيء نفيس خطير مصون ثَقَل ، فسمّاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكتاب والعترة بـ(الثقلين) ، إعظاماً لقدرهما وتفخيماً لشأنهما ، وأيضاً لأنّ الأخذ بهما ثقيل ، والعمل بهما ثقيل. يقال السيد العزيز ثَقَل من هذا ، وسمى الله تعالى الجن والإنس لتفضيله إياهما على سائر الحيوان والمخلوق في الأرض بالتمييز والعقل الذي خُصّا به. وقال ابن الأنباري : قيل للجن والإنس الثّقَلان ؛ لأنهما كالثّقَل للأرض وعليها. راجع : لسان العرب ، ج ١ / ٨٨.
الحـ ـ ج ـ ـ رف
جَارِيَة :
الحية من جنس الأفعى.
الجَبْلَة :
الجَبِلُ ككَتِف : السَّهم الجافي ، البَرْي ، أو كل غليظ جاف ، والأَنيثُ من النصال. راجع القاموس المحيط ، للفيروز آبادي / ٨٧٦.
الجَرْبُوعِيّة :
قرية تابعة للواء الحِلّة ، تقع على الطريق العام القديم من الكفل إلى الحِلّة ، بين الدبّلة والقاسم بن الإمام موسى عليه السلام. راجع : مراقد المعارف ، للشيخ محمد حرز الدين ، ج ٢ / ١٨.
جُوخَا :
إسم نهر عليه كورة واسعة في سواد بغداد بالجانب الشرقي منه الراذانان ، وهو بين خانقين وخوزستان ، قالوا : ولم يكن ببغداد مثل كورة (جُوخَا) ، كان خراجها ثمانين ألف درهم ، حتى صرفت دجلة عنها فخربت وأصابهم بعد ذلك طاعون شيروية فأتى عليهم.
وجوْخَاء : وهو موضع بالبادية بين عين صيد وزُبَالة في ديار بني عجل ، كان يسلكه حاج واسط. راجع : معجم البلدان للحموي ، ج ٢ / ١٧٨ ـ ١٧٩.
الجَوْشَن :
وهو الدرع ، ويوجد دعاءان بهذا الإسم : دعاء الجوشن الكبير المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، نزل به جبرئيل عليه السلام وهو في بعض غزواته ، وقد إشتدّت وعليه جوشن ثقيل آلمه ، فقال جبرئيل : يا محمد ، ربّك يقرأ عليك السلام ويقول لك : إخلع هذا الجوشن ، واقرأ هذا الدعاء ، فهو أمان لك ولأمتك. ودعاء الجوشن الصغير المروي عن الإمام الكاظم عليه السلام ، ودعا به علي بن موسى بن المهدي
العباسي ، بعد ما قتل الحسين بن علي صاحب فَخّ. راجع : سفينة البحار للقمي ، ج ١ / ٥٨٥ ـ ٥٨٦.
الحـ ـ ح ـ ـ رف
الحَرْمَل :
نبات أوراقه مصفوفة على جانبي الغصن ، وأزهاره مجتمعة على مستوى واحد ، حَبّه شبيه بالسمسم ، أنواعه متعددة ، يزرع في الحدائق وله فوائد طبية منها : أنه يوقف الإسهال ، ويصفي الدم ، وينفع من داء المفاصل. راجع : المنجد في اللغة / ١٣٠.
الحَرْمَلة : شجرة نحو الرُمّانة الصغيرة ، ورقها أدق من ورق الرُمّان ، خضراء تحمل جِراء دون جِراء العُشَر ، فإذا جفت إنشقت عن ألين قطن فتحشى به المِخاذّ ، وهو من الأغلاث. راجع : الإفصاح في فقه اللغة ، ج ٢ / ١١٠٠.
الحَرّة : الأرض التي قد ألبستها كلها حجارة سوداء كأنها أحرقت بالنار ، والجمع حِرَار. راجع الإفصاح في فقه اللغة ، ج ٢ / ١٠٢٦.
الحَسَك :
نبات شائك ، والعظم الدقيق من السمك. راجع : المنجد في اللغة / ١٣٣. واحدته حَسَكة : عشبة تضرب إلى الصفرة ، لها شوك مدحرج لا يكاد أحد يمشي فيه إذا يبس إلا من رجليه نعل ، ومن شوك الحسك سُمي الحَسَك الذي تُحصّن به العساكر ، تُبَثّ في مذاهب الخيل فَتَنْشَبُ في حوافرها. راجع : الإفصاح في فقه اللغة ، ج ٢ / ١١١٧.
الحَلْفى (الحَلْفَاء) :
نبات عِشْبِيّ مُعمِّر من الفصيلة النّخليّة ، موطنه جنوب أوروبا وشمال أفريقيا ، ولكنه يُزرع الآن بوفرة في مختلف أرجاء العالم ، في المناطق الصخرية والرملية ، يصل إرتفاع ساقه إلى ٩٠ سنتمتراً ، وهو قاسي الأوراق والسُّوق ، ومن أجل ذلك يستخدم في صناعة الورق ، وتتخذ منه الحبال والسلال والأخفاف. راجع : موسوعة المورد العربي ، ج ١ / ٤٤٥.
الحَلْفَاء : والحَلَف : نبت أطرافه محددة ينبت في مغايض الماء ، وهي سَلِبة غليظة المَسّ ، لا يكاد أحد يقبض عليها مخافة أن تقطع يده. واحدة الحلفاء واحدة وجمع ، وواحد الحَلَف حَلَفِة.
أحْلَفَت الحلفاء : نبتت. راجع : الإفصاح في فقه اللغة ، ج ٢ / ١١١٥.
الحُمّاض (الأُقصَلِيْس) : نبات عشبي من فصيلة الحُمّاضيّات ، يزرع بقلاً ، أوراقه غنية بحامض الأُقْصَلِيْس ، والواحدة حُمّاضَة جنس بنات عشبي ، من فصيلة اَلبَطْبَطِيّات ورقه كالهندباء ، له طعم فيه بعض الحموضة ، منه أنواع يزرع بعضها خاصة في أوروبا ، ويعد من البقول الزراعية. راجع : المنجد في اللغة / ١٥٥.
الحُمّاض : الحماض الأحمر : نبات من الفصيلة الخُبّازِيّة ، يزرع في غينيا والسنغال والسودان ، ويستعمل شراب منعش لذيذ الطعم ، هو المسمى الآن (الكَرْكَدية). راجع : الإفصاح في فقه اللغة ، ج ١ / ٤٧٦.
حُمَمَة :
جمع حُمَمَ : وهو كل ما احترق بالنار ، ويطلق على الرماد. راجع : المنجد في اللغة / ١٥٢.
الحُمَمَة : واحدة الحُمَمَ وهو الفحم. وقيل الحُمَمَ : ما أُحرق من خشب ونحوه ، وتطلق الحُمَمَة على الجَمْر مجاز باسم ما يؤول إليه. راجع : الإفصاح في فقه اللغة ، ج ٢ / ١١٩٠.
الحـ ـ خ ـ ـ رف
الخَزَرْ :
شعب تتاري عاش حول بحر قزوين ـ الذي يعرف أيضاً بسبب ذلك بـ(بحر الخَزَرْ) ـ وفي سفوح جبال اقوقاز ، من حوالي العام ١٩٠ للميلاد إلى العام ١١٠٠ م ، وقد أنشأ الخزر إمبراطورية تجارية ، بلغت أوج قوتها في النصف الثاني من القرن الثامن ، عندما إمتدت من نهر دنيبر غرباً ، إلى نهر الفولفا الأدنى ، وبحر قزوين شرقاً ، وفي منتصف القرن الثامن تهوّد كثير من الخزر على أيدي اليهود الذي غادروا القسطنطينية آنذاك هرباً من الاضطهاد. راجع : موسوعة المورد العربية ، ج ١ / ٤٦٤.
الحـ ـ د ـ ـ رف
الدَرَك :
الطبق الأسفل ؛ وذلك أنّ للنار سبع دركات ، سميت بذلك لأنّها متداركة متتابعة بعضها فوق بعض. ويقال : الدرك الأسفل : توابيت من حديد مبهمة عليهم لا أبواب لها. قال الشيخ أبو علي (الطبرسي) رحمه الله : أصل الدرك : الحبل الذي يوصل بها الرشا ويُعلّق به الدلو ، ثم لما كان في النار سفال من جهة الصورة ، والمعنى قيل له ذلك ، والمعنى أنّ النار طبقات ودركات ، كما أنّ الجنة درجات فيكون المنافق في أسفل طبقة منها لقبح فعله. والدرك بالتحريك ،
وقد يسكن : واحد الإدراك ؛ وهو منازل في النار. راجع : مجمع البحرين : ج ٥ / ٢٦٤.
الدغارة :
موضع من توابع (عفك) ، ضمن لواء الديوانية ، من المنطقة الوسطى في العراق ؛ أي في عشائر الفرات الأوسط. راجع : مراقد المعارف ، ج ١ / ٣٨٧.
الأدْغَال :
جمع دَغَل ، والدَغِيلَة : الشجر الكثير الملتف. راجع : المنجد في اللغة / ٢١٧.
الدِّفْلَى :
الحَبْن ، الحَبِين : نبتة دائما الخضرة من جنس «نيريوم» : ، أوراقها سهمية الشكل ، وزهراتها جميلة بيضاء أو أرجوانية أو قرنفلية عَطِرَة الرائحة ، أشهر أنواعها «الدفلى المألوفة» ، وموطن هذا النوع المناطق الإستوائية وشبة الإستوائية من آسيا ، وحوض الأبيض المتوسط ، ومن هناك أُدخِلَ إلى بعض البلدان الحارة الأخرى. راجع : موسوعة المورد العربية ، ج ١ / ٤٩٤.
الدَوْحَة :
جمعها دَوْح وأدواح : الشجرة العظيمة المتسعة ، أو المظلة العظيمة ، راجع : المنجد في اللغة / ٢٢٨.
الدوحة : الشجرة العظيمة. وقيل : هي المفترشة المتشعبة ذات الفروع الممتدّة. الجمع : دَوح ، وجمع الجمع : أدواح داحت الشجرةُ تدوح دَوْحَاً : عظمت. راجع : الإفصاح في اللغة ، ج ٢ / ١١٢٤.
الدَيْلَم :
القسم الجبلي من بلاد جيلان شمالي بلاد قزوين ، إعتنق بعض سكانه الإسلام ٩١٣ م ، وخدموا في جيش الخلفاء راجع : المنجد في الأعلام / ١٩٦.
الدِبابيج :
الديَباج : جمع ديابيج الواحدة ديباجة الثوب الذي سداه ولحمته حرير (فارسية) ، والمراد به ـ هنا ـ زهر النبات واختلاف ألوانه. والديباجة : الوجه ، يقال فلان يصون ديباجته أو يبدل ديباجته ؛ أي وجه فصون الديباجة كناية عن شرف الناس ، وبذلها كناية عن الدثاءة. راجع : المنجد في اللغة / ٢٠٥ ، والمجازات النبوية للشريف / ٨٤.
الدِوَانِيّة :
مدينة بالعراق قاعدة محافظة القادسية ، ومركز قضاء الديوانية. راجع : المنجد في الأعلام / ٢٩٧.
الدهاقين :
دِهْقَان : رئيس القرى وممثل الإقطاعية الصغرى في بلاد العجم في عهد الساسانيين. راجع : المنجد في الأعلام / ٢٨٩.
الحـ ـ ر ـ ـ رف
الرّقِيم :
يطلق الرقيم على ما يلي :
! ـ لوحات من نحاس مرقوم فيها ؛ أي مكتوب أمر الفتية وأمر إسلامهم ، وما أراد منهم دقيانوس الملك ، وكيف كان أمرهم وحالهم؟
ب ـ من أسماء الفلك ؛ سمي به لرقمه بالكواكب كالثوب المنقوش واللوح المكتوب ، وهذين المعنيين يرجعان إلى النقوش والكتابة. راجع : مجمع البحرين ، ج ٦ / ٨٤.
الرِوَاق :
والرِوَاق : جمع أرْوِقَة ورِوَاقَات ورُوق : سقف في مقدم البيت ، أو كساء على مقدم البيت من أعلاه إلى الأرض. ورواق العين حاجباها. راجع : المنجد في اللغة / ٢٨٨.
الرّمادي :
مدينة في العراق بالقرب من الفرات على طريق بغداد سورية. قاعدة محافظة الأنبار ومركز قضاء الرمادي.
راجع : المنجد في الأعلام / ٣٠٩.
السّاسانيون :
أسرة ملكية فارسية أسسها أردشير الأول عام ٢٢٤ للمبلاد ، بعد أن أطاح بالإمبراطورية البارثية أو الفَرْثية ، وقضى عليها العرب عام ٦٤٢ للميلاد ، تنسب إلى ساسان أحد أسلاف أردشير الأول ، من أشهر ملوكها سابور الأول ابن أردشير الأول ، وخليفته حكم من عام (٢٤١ إلى عام ٢٧٢ م) ، وفي عهده إمتدت حدود الإمبراطورية الساسانية ، من نهر السند شرقاً إلى أوج قوتها ومجدها. وفي عهد الساسانيين أصبحت الزّرادشتية دين الدولة الرسمي ، وازدهرت الحياة الفنّية ، عاصمتهم قَطْسيفون. راجع : موسوعة المورد العربية ج ١ / ٥٩٣.
السّاريَة :
ج سَوَار : الاسطوانة ، وعند المّلاحِين ، العمود الذي ينصب في وسط السفينة ؛ لتعليق القلوع به. راجع : منجد اللغة / ٣٣٢.
سدرة المنتهى :
وهي شجرة في أقصى الجنّة ، إليها ينتهي علم الأولين والآخرين ولا يتعداها. وفي علل الشرائع : «عن جيب السجستاني قال : قال أبو جعفر عليه السلام : (إنما سميت سدرة المنتهى ؛ لأنّ أعمال أهل الأرض تصعد بهم الملائكة الحفظة إلى محل السدرة. قال : والحفظة الكرام البررة دون السدرة ، يكتبون ما ترفعه إليهم الملائكة من أعمال العباد في الأرض ، فينتهي بها إلى محل السدرة). وفي كشف اليقين : عن الصادق عليه السلام : ـ في حديث المعراج ـ : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (وقف بي جبرئيل عند شجرة عظيمة لم أر مثلها ، على كل غصن منها وعلى كل ورقة منها ملك ، وعلى ثمرة منها ملك ، وقد كَلّلها نور من نور الله جَلّ وعَزّ ، فقال جبرئيل : هذه سدرة المنتهى ، كان ينتهي الأنبياؤ من قبلك إليها ، ثم لا يجاوزونها وأنت تجوزها إن شاء الله تعالى). راجع : سفينة البحار ، للشيخ عباس القمي ، ج ٤ / ١٨. ومستدرك السفينة ، للشيخ علي النمازي ، ج ٥ / ٨.
السامانيّون :
سلالة حكمت في ما وراء النهر وبخارى وسمرقند ٢٦١ ـ ٣٩٠ هـ / ٨٧٤ ـ ٩٩٩ م. أسسها سامان خُدَاه وأصبح حفدته الأربعة عمالاً للمأمون العباسي على سمرقند وفرغانه وهراة وشاش ، وإشتهر بينهم نصر الثاني (نوح الأول) ، إزدهرت الحضارة في عهدهم ، فنبغ الرودكي ، والفردوسي ، والرازي ، وابن سينا. قضى عليهم الغزنويون. راجع : المنجد في الأعلام / ٣٤٦.
سَنْدَان الهند :
هي قصبة بلاد الهند ، ولا أدري أي شيء أراد بهذا ، فإنّ القصبة في العرف : هل أجلّ مدينة في الكورة أو الناحية ، ولا نعرف بالهند مدينة يقال لها : سندان تكون كالقصبة ، إنما سندان مدينة في ملاصقة السند ، بينهما وبين الدَّيبُل والمنصورة نحو عشر مراحل ، ولم توصف صفة ما تستحق أن تكون قصبة الهند ، وبينها وبين البحر نحو نصف فرسخ ، وبينها وبين صَيْمور نحو خمس عشرة مرحلة. راجع : معجم البلدان ، ج ٣ / ٢٦٦ ـ ٢٦٧.
شَقَائِق النعمان :
جنس نبات من فصيلة الحَوْذَانِيّات أو الشَقِيْقِيّات ، يستعمل في الشرق الأوسط لتسمية عدة زهور ربيعية ، ذات لون أحمر جميل مثل الشُقّار الأحمر ، وحَوْزان الزَهّارين والخَشْخاض المنثور وسواها. راجع : المنجد في اللغة / ٣٩٦.
الشِعَاب :
جمع شِعْب : الطريق في الجبل ، مسيل الماء في بطن أرض ، أو ما انفرج بين الجبلين ؛ أي مجرى مائي ضيق ناشب في الجبل. راجع : معجم معالم الحجاز ، للمقدم البلادي ، ج ١ / ١٦ ، المنجد في اللغة / ٣٩٠.
الحـ ـ ط ـ ـ رف
الطّلَل :
جمع أطلال وطُلُول : الشاخص من آثار الدار ، وشخص كل شيء. راجع : القاموس المحيط ، للفيروز آبادي / ٩٢٤.
الحـ ع ـ ـ رف
العَالِم :
يطلق هذا اللقب على بعض الأئمة عليهم السلام وهم : (الصادق ، والكاظم ، والرضا ، والجواد ، والهادي). راجع : معاني الأخبار ـ للشيخ الصدوق / ٢٥٤ ، ومجموعتي ـ لمحمد علي دخيل ج ٢ / ١٦١ / ٢١٣.
عانة (عَنّة) :
بلدة في العراق ، مركز قضاء عَنّة (محافظة الأنبار). ورد ذكرها منذ العهد الآشوري ، عُرفت قديماً بعانات وتبوانا. راجع : المنجد في الأعلام / ٤٨٠.
عجمت الأمور :
عَجَم وعَاجّمَ : جَرّبَه ، يقال : (عاجمتُ الأمورَ وعاجمتني) ؛ أي جَرّبُتها وجَرّبتني. راجع : المنجد في اللغة / ٤٨٩.
عَدوّ شبّح :
شَبّح الشيء : جعله عريضاً ، وتَشبّح الحِرْبَاء على العود : إمتد. والمراد به ـ هنا ـ عَدوّ ظهر واشتد أمره. راجع : المنجد في اللغة / ٣٧١.
عَسَلان :
العَسَل : الإشتداد والإهتزاز والإضطراب ؛ ولذا يقال : عَسَل الرمح عَسْلاً وعُسُولاً وعَسَلاناً إشتد إهتزازه واضطرب ، وعسل الذئب والثعلب عَسَلاً وعَسَلاناً : مضى مسرعاً واضطرب في عَدْوه وهَزّ رأسه.
عُفَك :
مُعرَّب «عُفَجِ» ، بعين مهملة وفاء مفتوحة وجيم فارسية ، أرض قرب مقام شعيب عليه السلام ـ على الفرات شرقي الكوفة ـ عُرفت برجل اسمه محمد بن عُفاچ ، كُرفَاش بجيم فارسية. راجع : مراقد المعارف ، ج ١ / ٣٨٧ ـ ٣٨٨.
عَقِيرا :
قال السيد محسن الأمين (قده) : «وفي بعض حَوَاشيه على المصباح : أنّه حفر له أزج في كربلاء لدفنه فيه بأرض تسمى عقيراً». راجع أعيان الشيعة ، ج ٢ / ١٨٧. والمراد ب(أزج) ، جمع آزاج وآزج : البيت بيني طويلاً. راجع : المنجد في اللغة / ٩.
العَقِيق :
قال السيد أحمد الخياري : «وادي العقيق ، من أدوية المدينة المنورة الجبارة ، يقع في بلاد مزينة وينقسم إلى صغير وكبير ؛ فالكبير هذا ينقسم إلى قسمين ، فيكون وادي العقيق والحالة هذه صغير وكبير وأكبر ؛ تفصيل ذلك هو أنّ الصغير : هو الذي فيه بئر رومة ، وتسمى بئر عثمان ، وفيها الوحدة الزراعية ، وأنّ الكبير الذي فيه عروة وقصره ، وكان هذا يحتوي على أكثر من سبعين قصراً من القصور الفخمة والضخمة ، وذلك لطيب الهواء فيه وعذوبة الماء ، وأن الأكبر : هو الذي فيه بئر علي أو آبار علي ، وهو المحيط الذي أنشأ فيه سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ثلاثة وعشرين بئراً». راجع : تاريخ معالم المدينة المنورة / ١٩٩.
وقال المقدم عاتق البلادي : «العَقيق : أودية العقيق في الحجاز سبعة : عقيق المدينة وهو الأشهر ، والأكثر ذكراً في كتب التاريخ كما سيأتي :
يأخذ أعلى مساقط مياهه من قرب وادي الفرع ، ثم ينحدر شمالاً بين الحرار شرقاً ، وسلسلة جبال قُدْس غرباً ، حيث ترفده أودية عظيمة ، فيسمى هناك النّقِيع إلى أن يقرب من بئر الماشي عقيق الحَسَا ، وفي هذا المكان يعدل غرباً إلى الشمال ، إلى أن يصل بئار علي (ذي الحُلَيفة ، فيسمى العقيق فيعدل شمالاً ، يحف به من الشرق جبل عَيْر ، ومن الغرب البَيْدَاء ثم جماء تضارع ، وفيه مقاهٍ ونزلٍ وزراعة ، وفيه بئر عروة وقصره ، وقد جُعل له سداً يمر فوقه الطريق من المدينة إلى مكة ، ثم يستمر حتى يجتمع به وادي بطحان قرب مسجد القبلتين ، فيستمران إلى الجُرْف والغابة ، فيأتيهما من الشرق وادي قناة الذي يكون قد أخض السيل العقيق الشرقي ثم الخنق ، فإذا إجتمعت الأودية الثلاثة ـ العقيق ، وبطحان ، وقناة ؛ سُمي الوادي (الخُلَيل) تصغير ، فإذا تجاوز وادي مخِيط ؛ سمي وادي الحَمْض». معجم معالم الحجاز ، ج ٦ / ١٢٨ ـ ١٢٩.
عَاكِفُون على قبره :
عَكَفَ عكفاً وعَكُوفاً على الأمر : لزمه مواظباً. واعتكف في المكان : تحبّس فيه وليث وأقام فيه. راجع : المنجد في اللغة / ٥٢٢.
والعُشر :
هو عراض الورق ينبت صُعُداً في السماء. وله سُكّر يخرج من فصوص شُعبه ، ومواضع زهره فيه مرارة ، يخرج منه نُفّاخ كالشقائق ، وفي جوفه حُرّاق من أجود ما يُقتدح به ويُحشَى في المخاذ ، ويتخذ منه عُمُد وخّذاريف لخفّته. راجع : الإفصاح في فقه اللغة ، ج ٢ / ١١٠٠.
الحـ ـ غ ـ ـ رف
والأغلاث :
الغَلْثَى : شجرة مُرّة ، يقال : هذا النبات من الأغلاث ، فمنها العِكْرِش والحَلْفَاء ، والحاج ، واليَنبُوت ، واللصَف ، والعِشْرِق ، والأَسَل ، والبَرْديّ ، والحَنْظَل ، والتَنّوم ، والخِروَع. راجع : الإفصاح في فقه اللغة ، ج ٢ / ١١٠٤.
غَزْوَة ذات الرّقاع :
وقعت بعد غزوة بني النّضير بشهرين : قال البخاري : إنها كانت بعد خيبر ، لقي بها جمعاً من غَطَفَان ـ من قبائل العرب الشمالية ، من قيس عيلان ـ ، ولم يكن بينهما حرب ، وقد خاف النّاس بعضهم بعضاً حتى صلّى الله رسول الله صلاة الخوف ثم إنصرف بالناس ، وقيل : إنّما سميت ذات الرّقاع ؛ لأنه جبل فيه بقع حمرة وسود وبيضاء فسمي ذات الرّقاع. وقيل : إنما سمي بذلك ؛ لأنّ أقدامهم نقبت فيها ، فكانوا يلفون على أرجلهم الخرق. راجع : إعلام الورى ـ للشيخ الطبرسي / ٩٨ ـ ٩٩. والمنجد في الأعلام / ٥٠٨.
غَضَارَة من عَيْش :
الغَضَارَة : وجمعها غَضَائِر : النعمة وطيب العيش. راجع : المنجد في اللغة / ١٩.
الحـ ـ ف ـ ـ رف
فَجّ عميق :
الفَجّ : شُثة يكتنفها جَبَلان ، ويستعمل في الطريق الواسع وجمعه فِجَاج ، قال تعالى : ( مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ) [الحج / ٢٧]. راجع : المفردات في غريب القرآن ـ للراغب الإصفهاني ، ج ٢ / ٤٨٢.
لحـ ـ ق ـ ـ رف
القَاجَارِيين :
أسرة مالكة حكمت إيران من عام ١٧٩٤ م ، أوّل ملوكها آغا محمد خان ، وآخرهم أحمد شاه ، أطاح بها رضا شاه بلهوي عام ١٩٢٥ م ، في عهدها دخلت إيران في مدار السياسة الأوروبية ، وخسرت باكو ، وجورجيا ومعظم أرمينيا الفارسية ، بعد أن إستولت عليها دولة القياصرة في روسيا. راجع : موسوعة المورد العربية ، ج ١ / ٨٤.
القَاشِي (الكَاشِي) :
طابوق أزرق يُجلب من قَاشَان (كَاشَان) ؛ مدينة في الجزء الغربي من وسط إيران ، وهي عريقة في القدم ، وقد إشتهرت بصناعة الخزف المصقول ، وبالسجاد المصنوع من صوف وحرير. راجع : موسوعة المورد العربية ، ج ٢ / ٩٤٥.
قُدَيْد :
اسم موضع قرب مكة ، قال ابن الكلبي : لما رجع تُبّع من المدينة بعد حربه لأهلها ؛ نزل قُديْداً فهبّت ريح قَدّت خيم أصحابه فسمي قُديداً. وقال البكري : قرية جامعة ؛ وهي كثيرة المياه والبساتين. وروى ابن عباس : (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام حتى أتي قُديْداً ، ثم أفطر حتى أتى مكة). في الكتب القديمة : إنّ قديداً هو الوادي الذي وقعت فيه الريح لسليمان ، وأنه هو الذي أتى فيه بصاحبة سبأ. قام المقدم عاتق البلادي : «ويحف بقديد من الشمال «القديدية» حَرّة نُسبت إلى الووادي. كان إسمها المُشلّل ، يمر سيل قديد على (١٣٠) كيلاً شمالاً من مكة ، يقطعه الطريق هناك. وقد وهم حمد الجاسر حين قال : هو قرية ضعيفة بين خليص وعَسَفان. ووجه الوهم هنا :
١ ـ ليس قديد قرية ، إنما هو وادٍ عظيم كثير القرى ، يزيد عدد قراه عن أربعين قرية.
٢ ـ ليس بين خليص شمال عسفان ، فهو بين خليص ورابغ». راجع : معجم معالم الحجاز ، ج ٧ / ٩٦ ـ ٩٩.
قَرْقَرى :
القَرْقرة : صوت البطن ، قرر البطن : صَوّت من جوع أو غيره. والقرقرة هدير البعير إذا صفا صوته ورَجّع ، وقد قدقر ، والإسم القرقار. القرقرة : صوت الصُرّد والكركي والكروان. راجع : الإفصاح في فقه اللغة ، ج ١ / ٤٧٧ ، ٨٦٧.
الحـ ـ ك ـ ـ رف
الكَثِيب الأحمر :
الكثيب : القطعة من الرمل تنقاد مُحدّودِبة. والتّلّ من الرمل ، الجمع كُثْبَان وكَثُب واكتِبَة.
والكثيب الأحمر : ورد ذكره في عدة مواطن منها ما يلي :
١ ـ ذكر الشيخ الصدوق (قده) في الفقيه ، ج ٢ / ٣٢٥ : (فإذا غربت الشمس يوم عرفة فأفض وعليك السكينة والوقار ، وأفض بالإستغفار ، فإنّ الله يقول : ( ثُمَّ أَفِيضُوا ) الآية إلى أن قال : إذا أفضت فاقتصد في السير وعليك بالدعة ، واترك الوجيف الذي يصنعه كثير من الناس في الجبال والأودية ، فإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، كان يكفّ ناقته حتى يبلغ رأسها الورك ويأمر بالدعة ، وسنته السنة التي تتبع ، فإذا إنتهيت إلى الكثيب الأحمر ـ وهو على يمين الطريق ـ ؛ فقل : اللهم أرحم موقفي ، وبارك لي في عملي ، وسَلّم لي ديني ، وتقبل مناسكي). وورد تاريخياً وجغرافياً ذكر موضع في المزدلفة بعنوان (القرن
الأحمر) ؛ والقرن : هو الجبل الصغير المنفرد ، وعُيّن موقعه دون محسر على يمين القادم من منى ، فمن المحتمل أن يكون هو المقصود ، ويحتمل أيضاً أن يكون المقصود كثيباً كان أيام صدور النص ، ثم زالت معالمه.
٢ ـ في قصة شقيق البلخي مع الإمام الكاظم عليه السلام في فَيْد ، وقيل في شعر :
ثم عاينته ونحن نزولٌ |
دون فَيْدٍ على الكثيب الأحمر |
|
يضع الرمل في الإناء ويشربـ |
ـه فناديته وعقلي مُحيّر |
|
إسقني شربة قلّما سقاني |
منه عاينته سويقاً وسكّر |
|
فسألت الحجيج من يك هذا؟ |
قيل هذا موسى بن جعفر |
فَيْد : قال ياقوت الحموي : منزل بطريق مكة. وفيد : بلدة في نصف طريق مكة من الكوفة ؛ سميت فَيْدُ بفَيْد بن حام ؛ وهو أول من نزلها.
وخلاصة ما ذكره المقدّم عاتق بن غيث البلادي ؛ هو التالي :
«شِعي من روافد القاحة ـ تبعد عن مكة قرابة (١٤٠ كيلاً) في الشمال الشرقي ؛ وهي درب الحجيج القديم بين مكة والعراق ـ يَصبّ على الحَفَاة من الشمال ؛ وتقع الحَفَاة بعد (٢٣ كيلاً) من شرق الأثاية ، يفترق منها طريق الحاج (درب الأنبياء) ؛ وهي متسع نسبي كالدوّار ، تتكون فيه ثلاثة روافد وهي : الرصفة ، وشعب فَيْد : شِعب يأتي للحَفَاة من الشمال العدل ، يأخذه طريق الغائر يأخذ فَيْداً ، ثم يهبط طرفه اليدعة الشرقي ، ثم يأخذ ريع العقنقل ، ثم يهبط وادي الحلقة ، ثم يصعد الغائر. والرافد الثالث يسمى الحَفَاة أيضاً : يَصبّ من جبل قدس ؛ ويسمى الصافح الذي يسيل منه من قدس الحَفَاة ، فالحَفَاة مَحطّة وشِعب وجبل». راجع : معجم معالم الحجاز ، ج ٧ / ٦٥ ، ٧٨. وعلى طريق الهجرة / ٢٣٦.
وبعد هذا فالمستفاد من هذه الشواهد ، أنّ الكثيب الأحمر إسم عام يطلق على عدة أماكن ـ حسب المعنى اللغوي ـ ، وأما محل الشاهد ـ هنا ـ ؛ هو ما ذكرته الرواية التالية :
(مات هارون وموسى عليه السلام في التيه ، فروي : أنّ الذي حفر قبر موسى هو ملك الموت في صورة آدمي ؛ ولذلك لا يعرف بنو اسرائيل موضع قبر موسى عليه السلام. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قبره فقال : عند الطريق الأعظم ، عند الكثيب الأحمر). راجع : البحار ، ج ١٣ / ٣٦٣ ـ ٣٦٤. أيضاً : الإفصاح في فقه اللغة ، ج ٢ / ١٠٥٢ ، وهداية الناسكين / ١٩٥ ـ ١٩٦ ، للشيخ محمد حسن النجفي ، ومنهى الآمال ، ج ٢ / ٢٦٩ ، للشيخ عباس القمي. ومعجم البلدان ، ج ٤ / ٢٨٢ ـ لياقوت الحموي.
كُرَاع الغَمِيم :
كُرَاع : كراع كل شيء طرفه ، وكراع الأرض ناحيتها. وكراع : ما سال من أنف الجبل أو الحَرّة.
وكراع الغميم : موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة ؛ وهو وادٍ أمام عُسْفَان بثمانية أميال ، وهذا كراع جبل أسود في طرف الحرّة يمتد إليه. قلت تعرف كراع الغميم اليوم ببرقاء الغَمِيم ؛ وهي نُعْف من حَرّة ضَجْنَان ، يمتد شمالاً غربياً بين شامية ابن حماد والصُّغو ، على (١٦ كيلاً) من عُسْفَان على طريق مكة. راجع معجم معالم الحجاز. ج ٦ / ٢٦٥ وج ٧ / ٢١٢ ـ ٢١٣.
كوش (كيش) :
موضع أثري قريب من الحِلّة بالعراق. أطلال مدينة سومرية تعود إلى الألف الثالث قبل المسيح ، عُرفت باسم كيش (تَلّ الأحَمِر). راجع المنجد في الأعلام / ١٩٠.
الكَلْدَانَيُون :
شعب سامي مُترحل قديم ، إستقر في الجزء الجنوبي من بلاد بابل (حوالي ١٢٠٠ ـ ٨٠٠ ق. م) ، طلعت منهم أسرة مالكة حكمت بابل من (٦٢٥ إلى الغزو الفارسي عام ٦٣٩ ق. م). وقد أسسها بنو بولاشر ، ويطلق على الإمبراطورية البابلية في هذه المرحلة اسم الإمبراطورية الكلدانية ، أو الإمبراطورية البابلية المُحدَثة ، ويعتبر نبوخذ نَصّر الثاني أعظم ملوك بابل الكلدانيين ، ويُعدّ الكلدانيون من أكثر الشعوب القديمة عناية بعلم الفلك وعلم التنجيم. راجع : موسوعة المورد العربية ، ج ٢ / ٩٧٥.
الكوكب الدُرَّي :
الكوكب ، مفرد كواكب : وهو النجم. ووصف بالدريّ ؛ لأنّ الدريّ منسوب إلى الدرّ ، وشُبّه به لصفاته وإضاءته. راجع : إعراب القرآن وبيانه ، لمحي الدين درويش ، ج ٦ / ٦٠٥.
الحـ ـ م ـ ـ رف
اللّخْمِيُّون (المناذرة) :
سلالة عربية حكمت أجزاء من العراق ، من حوالي منتصف القرن الثالث للميلاد إلى مطلع القرن السابع ، كانت على تحالف مع الفرس ، وفي حرب مستمرة مع الغساسنة ، من أشهر ملوكها المنذر ابن ماء السماء (٥٠٣ ـ ٥٥٤ م) ، وابنه عمرو بن هند (٥٥٤ ـ ٢٦٩ م) ، الذي رعى ثلاثة من أصحاب المعلقات هم : طرفة بن العبد ، وعمر بن كلثوم ، والحارث بن حِلّزه ، والنعمان الثالث أبو قابوس (٥٨٠ ـ ٦٠٢ م) ، وقد إعتنق النصرانية وتمرّد على الفرس ، فخلعوه
عن العرش ، وبذلك زالت دولة اللّخميين ، كانت عاصمتهم الحيرة الواقعة على مقربة من مدينة الكوفة الحالية راجع : موسوعة المورد العربية ، ج ٢ / ١٠٣٣.
المُبَاهَلة :
إنّ مادة (بهل) تدلّ على شدة الإجتهاد والإسترسال في الأمر المطلوب ، وقد تستعمل في الإجتهاد في الدعاء ، سواء كان لعناً أم غيره ، ونبتهل ؛ أي يدعوا بعضنا على بعض ، ويختص هذا الدعاء ـ هنا ـ باللغة ويترتب على هذا أن يكون أحد الطرفين صادقاً والآخر كاذباً. وهيئة المباهلة ذكرتها بعض الروايات كالتالي :
عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المباهلة قال : (تُشبّك أصابعك في أصابعه ، ثم تقول : اللهم إن كان فلان جحد حقاً وأقرّ بباطل ؛ فأصبه بحسبان من السماء أو بعذاب من عندك ، وتلاعنه سبعين مرة).
وعن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : (الساعة التي تباهل فيها ما بين طلوع الفجر إلى طلوعه الشمس). راجع : مواهب الرحمن ، ج ٦ / ١٠ للسيد السبزواري. وأصول الكافي ، ج ٢ / ٥١٤ ـ للشيخ الكليني.
الملائكة المُرْدَفِين :
أي متبعين المؤمنين أو بعضهم بعضاً من أردفته أنا إذا جئت بعده ، راجع : مجمع البحرين ، ج ٥ / ٦٢ ـ للشيخ الطريحي ، والوافي ، ج ١٤ / ١٤٩٤ ـ للفيض الكاشاني.
الملائكة المسَوّمِين :
أي المعَلّمِين من التسويم ؛ بمعنى إظهار سيماء الشي ، كانت عليهم العمائم البيض المرسلة يوم بدر. راجع : الوافي ، ج ١٤ / ١٤٩٤.
المدْلَهِمّة :
الدَلْهَم : المظلم ، الليل الشديد. وفَلَاة مدلهم مدلهمة : لا أعلام فيها. راجع : لسان العرب ، ج ١٢ / ٢٠٦.
مِرْط من شَعَر :
المِرْط ، يجمع على مُرُوط : كل ثوب غير مخيط ، أو كساء من صوف ونحوه يؤتزر به. راجع : المنجد في اللغة / ٥٥٧ ، ومجمع البحرين ، ج ٤ / ٢٧٣.
مُغَافَصَة :
فاجأه وأخذه على غِرّة منه. الغَفِصَة ، ج غَوَافِص : الأزمة من أوزام الدهر. راجع : منجد اللغة / ٥٥٥.
المُوَنّق :
الأصل «نُوَقَة» فُعَلَة ؛ لأنها جمعت على نُوق مثل بُدْنَه وبُدْ. وقد جمعت في القلّة على أنّوق ، ثم استثقلوا الضمة على الواو فقدموها فقالوا : أونق ، ثم عَوّضوا الواو ياء فقالوا : أنيق ، ثم جمعوها على أيانق ، وتنوق في الأمر : تأنق فهي ، تَجوّد وبالغ في حسنه ، والإسم النَيّقة. راجع : مجمع البحرين ، ج ٥ / ٢٤٢.
مَلَل :
وادٍ من أودية المدينة يطؤه الطريق إلى مكة على (٤١ كيلاً) ، يسيل من السفوح الجنوبية الغربية لسلسلة جبال عوف (جبال قدس) ، ثم يتجه شمالاً مع ميل إلى الغرب ، فيدفع في وادي إضَم غرب المدينة على نحو ثلاثين كيلاً أو قريب من ذلك ، وهو قليل الزراعة قاحل كثير الروافد ، ومن روافده وادي الغُريش : يسيل من ورقان وما جاوره ، ووادي الجَفْر : من الفقارة وما جاورها ، ووادي الرِّمْث ، ووادي تُرْبان. راجع : معجم معالم الحجاز ، ج ٨ / ٢٦٠.
الحـ ـ ن ـ ـ رف
الأنْشَاز :
النَشْز : يجمع على نشوز وأنْشَاز : المكان المرتفع ، أو الإرتفاع مطلقاً. راجع : المنجد في اللغة / ١٥٥.
الحـ ـ هـ ـ ـ رف
وَهْدَة :
ج ، وِهَاد ، ووَهْدَة : الأرض المنخفضة. الهوَّة في الأرض. راجع منجد اللغة / ٩٢٠.
الحـ ـ هـ ـ ـ رف
الأهْوَار :
الهَوْر (اللاغون) : قناة أو بُحيرة ضَحْلَة نسبياً محادية للبحر ، ولكن يفصلها عنه مرتفعات أو حواجز مُرْمِلة ، أو جزر حاجزه أو شِعَاب مرجانية ، والأهوار تقع في جنوب العراق ، ومن أشهرها (هو الحمار) وتبلغ مساحته ٥٠٠٠ كلم ٢. راجع : موسوعة المورد العربية ، ج ٢ / ١٢٧٦ ، والمنجد في الأعلام / ٧٣٣.
هَمْدَان :
قبيلة قحطانية يمانية من كهلان ، كانت أراضيهم مركزاً لثقافة عربية عالية ، موقعها شمالي صنعاء وغربي مأرب ونجران ، وجنوبي الصحراء ، وشرقي أبي عريش ، عبدوا يغوث ويعوق ، وأسلموا على يد الإمام علي عليه السلام عام (٦٣١ م). راجع : المنجد في الأعلام / ٧٣٠.
هِيت :
مدينة في العراق : هي (إيتا أو اسيوبوليس القديمة) ، مركز قضاء هِيت (محافظة الأنبار). عندها كانت القوافل تقطع الفرات في طريقها إلى حلب ، بالقرب منها ينابيع النفط الشهيرة منذ العهدين الأشوري والبابلي. وفي عهد أمير المؤمنين وليها مالك الأشتر ، وكيل بن زياد. راجع : المنجد في الأعلام / ٧٣٥. ومراقد المعارف ، ج ٢ / ٢٢١ ، ٢٢٥.
مصادر البحث
مصادر البحث
ـ القرآن الكريم وتفسيره :
١ ـ البحراني (ت ١١٠٩ هـ) : السيد هاشم بن السيد سليمان الموسوي.
(البرهان في تفسير القرآن) ـ تحقيق لجنة من العلماء ـ بيروت ، مؤسسة الأعلمي ، ط ١ / ١٤١٩ هـ.
٢ ـ الحويزي (١١١٢ هـ) : الشيخ عبد علي بن جمعة العروسي.
(نور الثقلين) ـ تحقيق السيد علي عاشور ـ ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، ط ١ / ١٤٢٢ هـ.
٣ ـ الرازي (٦٠٦ هـ) : فخر الدين ، محمد بن عمر بن الحسين.
(التفسير الكبير ـ مفاتيح لغيب) ، بيروت ، دار الفكر ، ط ١ / ١٤٠١ هـ.
٤ ـ الزمخشري (٥٣٨ هـ) : جار الله ، محمود بن عمر الخوارزمي.
(الكَشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل) ، بيروت ، دار الفكر.
٥ ـ السبزواري (١٤١٤ هـ) : السيد عبد الأعلى بن السيد علي رضا الموسوي.
(مواهب الرحمان في تفسير القرآن) ، قم ، مؤسسة المنار ، ط ٣ / ١٤١٤ هـ.
٦ ـ الطباطبائي (١٤٠٢ هـ) : السيد محمد حسين.
(الميزان في تفسير القرآن) ، بيروت ، مؤسسة الأعلمي ، ط ٥ / ١٤٠٣ هـ.
٧ ـ الطبرسي (٥٤٨ هـ) : الشيخ أبو علي ، الفضل بن الحسن.
(مجمع البيان في تفسير القرآن) ـ تحقيق السيد هاشم الرسول المحلاتي ـ بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، ط / ١٤١٢ هـ.
٨ ـ الطوسي (٤٦٠ هـ) : الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسين.
التبيان في تفسير القرآن) ـ تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي ـ ، قم ، مكتب اللإعلام الإسلامي ، ط ١ / ١٤٠٩ هـ.
٩ ـ الفيض الكاشاني (١٠٩١ هـ) : الشيخ محمد محسن بن الشاه مرتضى.
(تفسير الصافي) ـ تصحيح العلامة الشيخ حسين الأعلمي ـ ، بيروت ، ط ١ / ١٣٩٩ هـ.
ـ الحديث :
١٠ ـ ابن حنبل (٢٤١ هـ) : أبو عبد الله ، أحمد بن محمد الشيباني.
(مسند بن حنبل) ، مصر ، الميمنة ، ط ١٣١٣ هـ.
١١ ـ ابن قولويه (٣٦٨ هـ) : الشيخ جعفر بن محمد.
(كامل الزيارات) ـ تحقيق الشيخ جواد القيومي ـ ، قم ، نشر الفقاهة ، ط / ١٤١٧ هـ.
١٢ ـ الحر العاملي (١١٠٤ هـ) : الشيخ محمد بن الحسن بن علي.
(وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة) ـ تحقيق الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي ـ بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، ط ٥ / ١٤٠٣ هـ. وتحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ، ط ١ / ١٤١٣ هـ.
١٣ ـ الحميري (القرن الثالث) : الشيخ عبد الله بن جعفر.
(قرب الإسناد) ـ تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ بيروت ، ط ١ / ١٤١٣ هـ.
١٤ ـ شبّر (١٢٤٢ هـ) : السيد عبد الله بن السيد محمد رضا.
مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار ـ تحقيق السيد علي بن السيد محمد شبّر ـ بيروت مؤسسة النور ، ط ٢ / ١٤٠٧ هـ.
١٥ ـ الشفائي () : حسين علي.
(قضاء أمير المؤمنين عليه السلام) ـ تعليق الأستاذ عبد الرحمن الخر ـ بيروت ، مؤسسة آهل البيت عليهم السلام.
١٦ ـ الشريف الرضي (٤٠٦ هـ) : محمد بن أبي أحمد ، الحسين الموسوي.
(المجازات النبوية) ـ تقديم طه عبد الرؤوف سعد ـ القاهرة ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، ط ١ / ١٣٩١ هـ.
١٧ ـ الصدوق (٣٨١) : الشيخ محمد بن علي بن بابويه.
! ـ (الأمالي) ، بيروت ، مؤسسة الأعلمي ، ط ٥ / ١٤٠٠ هـ.
ب ـ (معاني الأخبار) ـ تصحيح علي أكبر الغفاري ـ ، بيروت ، دار المعرفة ، ط / ١٣٩٩ هـ.
١٨ ـ الطبري (٦٩٤ هـ) محب الدين ، أحمد بن عبد الله.
(ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى) ، بيروت ، دار المعرفة.
١٩ ـ الطوسي (٤٦٠ هـ) : الشيخ محمد بن الحسن بن علي.
(تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد) ـ حققه وعَلّق عليه السيد حسن الخرسان ـ بيروت ، دار صعب ، ودار التعارف ، ط / ١٤٠١ هـ.
٢٠ ـ الفيض الكاشاني (١٠٩١ هـ) : الشيخ محمد محسن بن الشاه مرتضى.
(الوافي) ـ تحقيق السيد ضياء الدين الحسيني الإصفهاني ـ ، إصفهان ، مكتبة الإمام أمير المؤمنين ، ط / ١٤١٢ هـ.
٢١ ـ القشيري (٢٦١ هـ) : مسلم بن الحجاج.
(صحيح مسلم) ، مصر ، مطبعة بولاق ، سنة / ١٢٠٩ هـ.
٢٢ ـ الكليني (٣٢٩ هـ) : الشيخ محمد بن يعقوب إسحاق الرازي.
(أصول الكافي) ـ صححه وعَلّق عليه علي اكبر الغفاري ـ ، بيروت ، دار صعب ، ودار التعارف ، ط ٤ / ١٤٠١ هـ.
٢٣ ـ المحمودي (معاصر) : محمد جواد.
(ترتيب الأمالي) ، قم ، مؤسسة المعارف الإسلامية ، ط ١ / ١٤١٢ هـ.
٢٤ ـ المجلسي (١١١١ هـ) : الشيخ محمد باقر بن الشيخ محمد تقي.
١ ـ (بحار الأنوار ، الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار) ـ تحقيق مجموعة من العلماء ـ ، بيروت ، مؤسسة أهل البيت (ع) ، ط ٤ / ١٤٠٩ هـ.
٢ ـ (مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول) ـ إخراج وتصحيح السيد هاشم الرسولي وآخرون ـ طهران ، دار الكتب الإسلامية.
٢٥ ـ المفيد (٤١٣ هـ) : الشيخ محمد بن محمد النعمان.
(الأمالي) ـ تحقيق علي أكبر الغفاري وآخر ـ ، بيروت ، دار المفيد ، ط ٢ / ١٤١٤ هـ.
٢٦ ـ المرعشي (١٤١١ هـ) : السيد شهاب الدين بن السيد محمود الحسيني النجفي.
(ملحقات إحقاق الحق) ، قم ، منشورات مكتبة السيد المرعشي.
٢٧ ـ النوري (١٣٢٠ هـ) : ميرزا حسين الطبرسي.
(مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل) ـ تحقيق مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث ـ قم ، دار الهداية ، ط ٥ / ١٤١٢ هـ.
٢٨ ـ الهيثمي (٨٠٧) : الحافظ نور الدين ، علي بن أبي بكر.
(مجمع الزوائد) ، القاهرة ، مكتبة القدسي.
٢٩ ـ ابن الأثير (٦٠٦ هـ) : مجد الدين ، المبارك بن محمد الجزري.
(النهاية في غريب الحديث والأثر) ـ تحقيق طاهر أحمد الزاوي وآخر ـ ، بيروت ، دار الفكر ، ط ٢ / ١٣٩٩ هـ.
٢٠ ـ ابن منظور (٧١١ هـ) : محمد بن مكرم بن علي الأنصاري.
(لسان العرب) ، بيروت ، دار صادر ، ط ١ / ١٤١٢ هـ.
٣١ ـ البغدادي (٧٣٩ هـ) : صفي الدين ، عبد المؤمن عبد الحق.
(مراصد الإطلاع في معرفة البقاع) ـ تحقيق علي محمد البجاوي ـ بيروت ، دار المعرفة ، ط ١ / ١٣٧٣ هـ.
٣٢ ـ الحموي (٦٢٦ هـ) : شهاب الدين ، ياقوت بن عبد الله الرومي.
(معمجم البلدان) بيروت ، دار صادر ، ط ٢ / ١٩٩٥ م.
٣٣ ـ الراغب الإصفهاني (٥٠٢ هـ) : أبو القاسم ، الحسين بن محمد.
(المفردات في غريب القرآن) ـ تحقيق مركز الدراسات بمكتبة نزار مصطفى الباز ـ ، مكة المكرمة ، ط ١ / ١٤١٨ هـ.
٣٤ ـ الزبيدي (١٢٠٥ هـ) : السيد محمد بن محمد بن مرتضى الحسيني.
(تاج العروس من جواهر القاموس) ـ تحقيق عبد الكريم العزباوي وآخرون ـ ، بيروت ، دار الهداية.
٣٥ ـ الشافعي (٢٠٤ هـ) : محمد بن إدريس.
(ديوان الإمام الشافعي) ـ إعداد الدكتور رحاب عكاوي ـ ، بيروت ، دار الفكر العربي ، ط ١ / ١٩٩٢ م.
٣٦ ـ شريف (معاصر) : الدكتور محمد أبو الفتوح.
(التركيب النحوي وشواهده القرآنية) ، دبي ، دار القلم ، ط ١ / ١٤٠٨ هـ.
٣٧ ـ الطريحي (١٠٨٥ هـ) : الشيخ فخر الدين بن الشيخ محمد علي.
(مجمع البحرين) ـ تحقيق أحمد الحسيني ـ ، بيروت ، مؤسسة الوفاء ، ط ٢ / ١٤٠٣ هـ.
٣٨ ـ الفراهيدي (١٧٥ هـ) : الخليل بن أحمد.
(كتاب العين) ـ تحقيق الدكتور مهدي المخزومي وآخر ـ ، قم ، منشورات دار الهجرة.
٣٩ ـ الأنطاكي () : محمد.
(المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها) ، بيروت ، دار الشرق العربي ، ط ٣ /
٤٠ ـ اليسوعي () : الأب فردينان توتل ـ ولويس معلوف.
(المنجد في اللغة والأعلام) ـ حرره مجموعة من الأعلام ـ ، بيروت ، دار الشرق ، ط ١٠ / ١٩٧٣ م.
ـ الفقه والأصول :
٤١ ـ ابن إدريس (٥٩٨ هـ) : الشيخ محمد بن منصور بن احمد الحِلِّي.
(كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوِي) ـ تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي ـ ، قم ، ط ٢ /
٤٢ ـ بحر العلوم (١٢١٢ هـ) : السيد محمد مهدي بن السيد مرتضى.
(الدرّة النجفية) ، بيروت ، دار الزهراء ، ط ٢ / ١٤٠٦ هـ.
٤٣ ـ البحراني (١١٨٦ هـ) : الشيخ يوسف بن الشيخ أحمد الدرازي.
(الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة) ـ تحقيق محمد تقي الإيرواني ـ ، قم ، مؤسسة النشر الإسلامي.
٤٤ ـ البروجردي (١٤١٩ هـ) : الشيخ مرتضى ابن الشيخ علي محمد.
(مستند العروة الوثقى) ـ تقريراً لبحث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي ـ قم ، المطبعة العلمية ، ط / ١٤١٣ هـ.
٤٥ ـ التبريزي (معاصر) : الشيخ ميرزا جواد.
(صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات) ـ قم ، دار الصديقة الشهيدة ، ط ١ / ١٤٢٣ هـ.
٤٦ ـ الجزيري (١٣٦٠ هـ) : عبد الرحمن بن محمد عوض.
(كتاب الفقه على المذاهب الأربعة) ـ إعتنى بها عبد اللطيف بيتيّة ـ ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي.
٤٧ ـ الحكيم (١٣٩٠ هـ) : السيد محسن بن السيد مهدي الطباطبائي.
(منهاج الصالحين) ، النجف الأشرف ، مطبعة النعمان ، ط ١٢ / ١٣٨٤.
٤٨ ـ الخوئي (١٤١٣ هـ) : السيد أبو القاسم بن السيد علي أصغر الموسوي.
(منهاج الصالحين) ، النجف الأشرف ، ط ٨ / ١٤٠٧ هـ.
٤٩ ـ الخاقاني (معاصر) : الشيخ محمد بن الشيخ طاهر آل شبير.
(المحاكمات بين الكفاية والأعلام الثلاثة) ـ تقريراً لبحث آية الله العظمى الشيخ محمد طاهر الخاقاني.
٥٠ ـ السبزواري (١٤١٤ هـ) : السيد عبد الأعلى بن السيد علي رضا الموسوي.
(مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام) ، قم ، مؤسسة المنار ، ط ٤ / ١٤١٣ هـ.
٥١ ـ السيوري (٨٢٦ هـ) : الشيخ جمال الدين ، مقداد بن عبد الله.
(التنقيح الرائع لمختصر الشرائع) ـ تحقيق السيد عبد اللطيف الحسيني ـ قم مطبعة الخيام ، ط ١ / ١٤٠٤ هـ.
٥٢ ـ الشهيد الأول (٨٧٦ هـ) : الشيخ محمد بن مكي العاملي.
أ ـ (ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة) ، بيروت ، مؤسسة آل البيت ، ط ١ / ١٤١٩ هـ.
ب ـ (القواعد والفوائد في الفقه والأصول والعربية) ـ تحقيق الدكتور السيد عبد الهادي الحكيم ـ النجف الأشرف ، مطبعة الآداب ، ط ١ / ١٩٨٠ م.
٥٣ ـ الشهيد الثاني (٩٦٥ هـ) : الشيخ زين الدين بن علي العاملي.
(مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام) ـ تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الإسلامية ، قم ، ط ١ / ١٤١٣ هـ.
٥٤ ـ النجفي (١٢٢٦ هـ) : الشيخ محمد حسن بن باقر.
(جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام) ـ تحقيق الشيخ عباس القوچاني ـ ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، ط ٧ / ١٩٨١ م.
٥٥ ـ اليزدي (١٣٣٧ هـ) : السيد محمد كاظم بن السيد عبد العظيم الطباطبائي.
(العروة الوثقى) ، بغداد ، دار السلام ، ط ٢ / ١٣٣٠ هـ.
ـ عقيدة ودعاء :
٥٦ ـ ابن حجر (٨٥٢ هـ) : شهاب الدين ، أحمد بن علي الهيثمي.
(الصواعق المحرقة ، في ال رد على أهل البدع والزندقة) ـ تعليق عبد الوهاب عبد اللطيف ـ القاهرة ، مكتبة القاهرة ، ط ٢ / ١٣٨٥ هـ.
٥٧ ـ ابن طاووس (٦٦٤ هـ) : السيد رضي الدين ، علي بن موسى الحسني الحسيني.
(مهج الدعوات ومنهج العبادات) ، بيروت ، مؤسسة الهدى الإسلامية للنشر ، ط ١ / ١٤٠٧ هـ.
٥٨ ـ ابن فهد (٨٤١ هـ) : الشيخ أحمد بن فهد الحلي.
(عُدّة الداعي ونجاح الساعي) ـ صححه وعَلّق عليه أحمد الموحدي القمي ـ ، بيروت ، دار المرتضى ، ط ١ / ١٤٠٧ هـ.
٥٩ ـ الأميني (١٣٩٠ هـ) : الشيخ عبد الحسين بن الشيخ أحمد.
١ ـ (الغدير في الكتاب والسنة والأدب) ، طهران ، دار الكتب الإسلامية.
٢ ـ (سيرتنا وسنتنا) ، بيروت ، دار الكتاب الإسلامي ، ط ٢ / ١٤١٢ هـ.
٦٠ ـ البحراني (معاصر) : السيد محمد بن صالح بن السيد عدنان الموسوي.
(النمارق الفاخرة إلى طرائق الآخرة) ، بيروت ، الأعلمي للمطبوعات ، ط ١ / ١٤٠٨ هـ.
٦١ ـ البهائي (٩٥٣ هـ) : الشيخ محمد بن الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي.
(الكشكول) ـ قَدّم له الدكتور السيد محمد بحر العلوم ـ ، بيروت ، دار الزهراء ، ط ٢ / ١٤٠٣ هـ.
٦٢ ـ التستري (١٣٠٣ هـ) : الشيخ جعفر ابن المولى حسين.
(الخصائص الحسنية) ـ حققه السيد جعفر الحسيني ـ ، بيروت ، دار السرور ، ط ١ / ١٤١٤ هـ.
٦٣ ـ السبزواري (١٢٨٩) : الحكيم الملا هادي بن مهدي.
(شرح دعاء الجوشن الكبير) ـ تحقيق الدكتور نجفقلي حبيبي ـ ، طهران ، جامعة طهران ط ١ / ١٣٧٣ هـ. ش.
٦٤ ـ شبّر (١٢٤٢) : السيد عبد الله بن السيد محمد رضا.
(حق اليقين في معرفة أصول الدين) ، بيروت ، دار الأضواء ، ط ١ / ١٤٠٤ هـ.
٦٥ ـ شرف الدين (١٣٨٧ هـ) : السيد عبد الحسين بن السيد يوسف الموسوي العاملي.
أ ـ (فلسفة الميثاق والولاية) ، النجف الأشرف ، دار النعمان ، ط / ١٣٨٧ هـ.
ب ـ (الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء) ، البحرين ، دار أهل البيت (ع).
٦٦ ـ الطوسي (٤٦٠ هـ) : الشيخ محمد بن الحسن بن علي.
(مصباح المتهجد) ـ صححه وأشرف على طباعته الشيخ حسين الأعلمي ـ بيروت ، مؤسسة الأعلمي ، ط ١ / ١٤١٨ هـ.
٦٧ ـ طوق (١٢٤٥ هـ) : الشيخ أحمد بن الشيخ صالح.
(رسائل آل طوق القطيفي) ـ تحقيق دار المصطفى لإحياء التراث ـ ، بيروت ، ط ١ / ١٤٢٢ هـ.
٦٨ ـ العسكري (معاصر) : السيد مرتضى.
(معالم المدرستين) ، بيروت ، مؤسسة النعمان ، ط / ١٤١٠ هـ.
٦٩ ـ الفاكهي (٩٧٢ هـ) : جمال الدين ، عبد الله بن أحمد المكي.
(حسن التوسل في آداب زيارة أفضل الرسل) ـ المطبوع بهامش كتاب (الإتحاف بحب الأشراف) ـ ، مصر / ١٣١٨ هـ.
٧٠ ـ فلسفي (١٤٢٢ هـ) : الشيخ محمد تقي.
(الطفل بين الوراثة والتربية) ـ تعريب السيد فاضل الميلاني ـ ، بيروت ، دار التعارف ، ط ١ / ١٤٠١ هـ.
٧١ ـ كاشف الغطاء (١٣٧٣ هـ) : الشيخ محمد حسين بن الشيخ علي.
(جنة المأوى) ، بيروت ، دار الأضواء ، ط ٢ / ١٤٠٨ هـ.
٧٢ ـ الكفعمي (٩٠٠ هـ) : الشيخ إبراهيم بن علي العاملي.
(البلد الأمين والدرع الحصين) ـ قَدّم له وعلق عليه علاء الدين الأعلمي ـ بيروت ، مؤسسة الأعلمي ، ط ١ / ١٤١٨ هـ.
٧٣ ـ محدثي (معاصر) : جواد.
(موسوعة عاشوراء) ـ ترجمة خليل زامل العصامي ـ بيروت ، دار الرسول الأكرم ، ودار الحجة البيضاء ، ط ١ / ١٤١٨ هـ.
٧٤ ـ المامقاني (١٣٥١ هـ) : الشيخ عبد الله بن محمد حسن.
(مرآة الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال) ـ تحقيق الشيخ محيي الدين المامقاني ـ ، قم ، ط ٢ / ١٤١٤ هـ.
٧٥ ـ موسوعة كلمات الحسين ـ إعداد لجنة الحديث في معهد تحقيقات باقر العلوم ـ ، قم ، نشر دار المعروف ، ط ٢ / ١٤١٥ هـ.
ـ تاريخ :
٧٦ ـ البلادي (معاصر) : المقدم عاتق بن غيث.
١ ـ (معجم معالم الحجاز) ـ مكة المكرمة ، دار مكة ، ط ١ / ١٣٩٨ هـ ـ ١٤٠٣ هـ.
٢ ـ (معالم مكة التأريخية والأثرية) ، مكة المكرمة ، دار مكة ، ط ٢ / ١٤٠٣ هـ.
٧٧ ـ البحراني (القرن ١٢ هـ) : الشيخ عبد الله بن نور الله.
(عوالم العلوم ـ الإمام الحسين (ع)) ، قم ، مدرسة الإمام المهدي ، ط / ١٤٠٩ هـ.
٧٨ ـ ابن خلكان (٦٨١ هـ) : أحمد بن محمد بن أبي بكر.
(وفيات الأعيان) ، مصر ، ١٣١٠ هـ.
٧٩ ـ ابن طاووس (٦٦٤ هـ) : السيد علي بن السيد موسى الحسني الحسيني.
(اللهوف على قتلى الطفوف) ، النجف الأشرف ، المكتبة الحيدرية ، ط / ١٣٨٥ هـ.
٨٠ ـ ابن كثير (٧٧٤ هـ) : عماد الدين ، إسماعيل بن عمر.
أ ـ (إستشهاد الحسين) ـ تقديم الدكتور محمد جميل غازي ـ جدة ، مطبعة المدني.
ب ـ (البداية والنهاية) ، مصر ، دار السعادة.
٨١ ـ البهبهاني (١٢٨٥ هـ) : الشيخ محمد باقر ابن المولى عبد الكريم الدهدشتي.
(الدمعة الساكبة في المصيبة الراتبة) ، بيروت ، مؤسسة الأعلمي ، ط ١ / ١٤٠١ هـ.
٨٢ ـ حرز الدين (١٣٦٥ هـ) : الشيخ محمد بن الشيخ علي.
(مراقد المعارف) ـ تحقيق محمد حسين حرز الدين ـ ، النجف الأشرف / مطبعة الآداب ، ط ٢ / ١٣٩١ هـ.
٨٣ ـ الخليلي (١٤٠٦ هـ) : جعفر بن الشيخ أسد الله بن المولى علي.
(موسوعة العتبات المقدسة) ، بيروت مؤسسة الأعلمي ، ط ٢ / ١٤٠٧ هـ.
٨٤ ـ الخوارزمي (٥٦٨ هـ) : الموفق بن أحمد المكي.
(مقتل الحسين) ـ تحقيق الشيخ محمد السماوي ـ ، قم أنوار الهدى ، ط ١ / ١٤١٨ هـ.
٨٥ ـ الخياري (١٣٨٠ هـ) : السيد أحمد ياسين أحمد.
(تاريخ معالم المدينة المنورة قديماً وحديثاً) ـ تعليق وإيضاح عبيد الله محمد أمين كردي ـ ، جدة ، دار العلم ، ط ٢ / ١٤١١ هـ.
٨٦ ـ الدجيلي (معاصر) : جعفر هادي.
(موسوعة النجف الأشرف) ـ بإشراف لجنة من رجال الفكر والعلم والأدب ـ ، بيروت ، دار الأضواء ، ط ١ / ١٤١٣ هـ.
٨٧ ـ الشهرستاني (١٣٩٥ هـ) : السيد صالح بن السيد إبراهيم الموسوي.
(تاريخ النياحة على الإمام الشهيد الحسين بن علي (ع)) ـ تحقيق نبيل رضا علوان ـ بيروت ، دار الزهراء ، ط ١ / ١٤١٩ هـ.
٨٨ ـ الشهرستاني (١٣٨٦ هـ) : السيد هبة الدين ، محمد علي بن الحسين الحسيني.
(نهضة الحسين) ، بيروت ، دار الكتاب العربي.
٨٩ ـ الصدر (١٣٥٤ هـ) : السيد حسن بن السيد هادي الموسوي.
(تأسيس الكرام لعلوم الإسلام) ، بيروت ، مؤسسة أهل البيت (ع).
٩٠ ـ طعمة (معاصر) : السيد سلمان هادي.
١ ـ (تراث كربلاء) ، بيروت ، مؤسسة الأعلمي ، ط ٢ / ١٤١٦ هـ.
٢ ـ (تاريخ مرقد الحسين والعباس) ، بيروت ، مؤسسة الأعلمي ، ط ١ / ١٤١٦ هـ.
٣ ـ (دليل كربلاء المقدسة) ، بيروت ، دار المرتضى ، ط ١ / ١٤٢١ هـ.
٩١ ـ طعمة (١٩٦٩ هـ) : السيد عبد الجواد بن السيد علي الكليدار.
(تاريخ كربلاء وحائر الحسين (ع)) ، قم ، منشورات الشريف الرضي.
٩٢ ـ الكرباسي (معاصر) : الشيخ محمد صادق.
(دائرة المعارف الحسينية ـ تاريخ المراقد ، ج ١) ، لندن ، المركز الحسيني للدراسات ، ط ١ / ١٤١٩ هـ.
٩٣ ـ المسعودي (٣٤٥ هـ) : علي بن الحسين.
(إثبات الوصية) ، بيروت ، دار الإرشاد.
٩٤ ـ المظفر (١٣٩٥ هـ) : الشيخ عبد الواحد بن الشيخ أحمد.
(بطل العلقمي) ، النجف الأشرف ، المطبعة الحيدرية ، ط ١ / ١٣٧١ هـ.
٩٥ ـ المفيد (٤٧٣ هـ) : الشيخ محمد بن محمد النعمان.
(الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد) ـ تحقيق مؤسسة آل البيت (ع) لتحقيق التراث ، بيروت ، دار المفيد ، ط ٢ / ١٤١٤ هـ.
٩٦ ـ المقرّم (١٣٩١ هـ) : السيد عبد الرزاق الموسوي.
(مقتل الحسين) ـ قَدّم له محمد حسين المقرم ـ ، بيروت ، دار الكتاب الإسلامي ، ط ٥ / ١٤٠٨ هـ.
٩٧ ـ الدربندي (١٢٨٥ هـ) : الشيخ آغا عابد الشيرواني.
(إكسير العبادات في أسرار الشهادات) ـ تحقيق محمد جمعة وآخر ـ ، المنامة ، شركة المصطفى ، ط ١ / ١٤١٥ هـ.
٩٨ ـ السمهودي (٩١١ هـ) : نور الدين ، علي بن أحمد الحسني.
(وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى) ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ـ ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط ٤ / ١٤٠٤ هـ.
٩٩ ـ نور ولي (معاصر) : عبد العزيز محمد.
(أثر التشيع على الروايات التاريخية في القرن الأول الهجري) ، المدينة المنورة ، دار الخضيري ، ط ١ / ١٤١٧ هـ.
١٠٠ ـ الواقدي (٢٠٧ هـ) : محمد بن عمر.
(المغازي) ـ تحقيق د/ مارسدون جونس ـ ، بيروت ، عالم الكتب.
الفهرس
مقدمة البحث ٥
بسم الله الرحمن الرحيم ٧
البحث الأول ١٥
بحوث تمهيدية ١٧
الجانب اللغوي للإسم ١٩
الجانب الديني للإسم ٢٥
الجانب الإجتماعي للإسم ٤١
أسماء شرف وقداسة ٥١
أسماء تاريخية ١٦١
أسماء طبيعية ١٧٩
نتائج البحث ٢٠٣
٦ ـ المجاورة في كربلاء والأماكن المقدسة ٢٣٧
نتائج ٢٨١
تساؤلات البحث ٢٨١
معجم الألفاظ ٢٨٩
مصادر البحث ٣١٩
مصادر البحث ٣٢١
الفهرس ٣٣٥