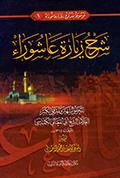شرح زيارة عاشوراء
شرح زيارة عاشوراء
المؤلف: الشيخ أبي المعالي الكلباسي
المحقق: الشيخ يوسف أحمد الأحسائي
بسم الله الرحمن الرحيم
السَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ ،
السَّلَامُ عَلَى الْحُسَيْنِ
وَعَلىٰ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ،
وَعَلىٰ أَوْلادِ الْحُسَيْنِ ،
وَعَلىٰ أَصْحابِ الْحُسَيْنِ ،
مقدّمة
موسوعة شروح زيارة عاشوراء
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وصلى الله على محمّد وآله الطاهرين
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
منذ أن بزغ نور هذا الدين وهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحسين عليه السلام ، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وآله يشيد به عليه السلام في كثير من المواقف منذ أن كان الحسين عليه السلام وليداً إلى يوم رحيل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله عن هذه الدنيا ، فتراه يرثيه باكياً في يوم ولادته أمام جمع من المسلمين ، ويرثيه في يوم رحيله وهو على فراش المرض.
وما بين هاتين المرحلتين الكثير من المواقف التي صدرت منه صلى الله عليه وآله في شأن الحسين عليه السلام ، والتي لسنا بصدد تتبعها في هذه المقدمة ، وكان من أهمها مقولة رسول الله صلى الله عليه وآله المشهورة «حُسَينٌ مِنِّي وَأَنَا مِن حُسَينٍ ، أَحَبَّ اللهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيناً » هذه المقولة التي تكشف بجلاء ما للحسين عليه السلام من مقام شامخ مرتبط بهذا الدين كما هو مقام رسول الله صلى الله عليه وآله.
فكيف لنا في هذه العجالة أن نحيط بمقامات الحسين عليه السلام الذي هو من رسول الله ورسول الله منه؟ كيف لنا أن نحيط بأسرار الحسين وأبعاده وهو بهذه المنزلة العظيمة الشامخة؟
إلّا أنّه هناك بُعد ومقام خاصّ يربطنا بالحسين عليه السلام ألا وهو بعد الزيارة ، هذا البعد الذي أكّدت عليه النصوص الكثيرة الواردة عن أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام ، بل قد لا تجد أحداً من المعصومين تمّ التأكيد على زيارته كما حصل لزيارة الحسين عليه السلام ، فدونك ما دون في شأن زيارته عليه السلام في كتب الأدعية والزيارات وفي الكتب المطولات ، فإنّه ممّا لا يحصى كثرة ولا يسع المجال تتبعاً ، ولا نظن أن يخفى هذا البعد على طالب صغير فضلاً عن غيره.
فلا تكاد ترى مناسبة مهمة إلّا وتجد لزيارته عليه السلام موقعاً أساسياً في أعمال تلك المناسبة ، فها هي مناسبة ليالي القدر وليالي العيدين وقد احتلت زيارته عليه السلام فيها الموقع المهم ، ومثلها زيارته عليه السلام في يوم عرفة ، وكذلك زيارته عليه السلام في النصف من شهر شعبان ، وزيارته عليه السلام في النصف من شهر رجب ، وكذلك زيارته عليه السلام في يوم الأربعين ، وغيرها الكثير فضلاً عن الزيارات المطلقة.
والأهم من بين هذه الزيارات زيارته في يوم شهادته عليه السلام ، يوم قارع الظلم وفدى هذا الدين بأغلى ما يملك وهو نفسه الزكيّة الطاهرة ، حيث جاد بنفسه وأهل بيته وأصحابه قتلاً ونسائه وعائلته سبياً وتشريداً يُطافُ بهنّ من بلد إلى بلد وهن حرائر بيت الوحي وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ، كل ذلك كان بعين الله ومشيئته سبحانه تقدّست آلاؤه ، وقد أفصح عليه السلام عن ذلك عندما سئل عن السبب في أخذه لعائلته ونسائه فقال : «شاء الله أن يراني قتيلاً ، وأن يرى النساء سباياً » ، هذا اليوم الذي تجسدت فيه روح الفداء لهذا الدين بأسمى معانيها وفي المقابل تجسدت فيه روح الظلم والعدوان بأبشع صورها ، فكان حق الحسين عليه السلام أن يزار في هذا اليوم بزيارة تتناسب مع هذه المعاني المتجسدة في ذلك اليوم ، وهذا عينه ما حصل من أئمّة الهدى عليهم السلام ، حيث رويت زيارته عليه السلام في يوم عاشوراء بطرق متعدّدة عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام ، هذه الزيارة التي جسّدت الولاء الحقيقي للحسين عليه السلام ، والذي هو بدوره جسّد روح الولاء والتضحية لهذا الدين ، كما أكّدت هذه الزيارة على البراءة
الحقيقيّة من أعدائه وأعداء أهل البيت عليهم السلام ، أعداؤهم الذين جسّدوا روح العداء والظلم بأبشع الصور وأشنعها.
هذه الزيارة التي ما فتئ علماؤنا رضوان الله عليهم من الترنّم بها وجعلها ورداً خاصاً يلتزمون به في أيام حياتهم ، ولم يكن ذلك الالتزام منهم إلّا تمسّكاً بكلام الأئمّة عليهم السلام ، فإنّ هذا عينه ما نصّ عليه الإمام عليه السلام لعلقمة بن محمّد ، حيث قال له : «وإن استطعت أن تزوره في كلّ يوم بهذه الزيارة في دارك فافعل ، فلك ثواب ذلك ...».
كما أنه قلّما تجد كتاباً مدوّناً لجمع الأدعية والزيارات إلّا وتجد هذه الزيارة في صدارة زياراته عليه السلام ، فدونك ما سطّره أعلام الطائفة من القرن الثالث والرابع الهجري إلى يومنا هذا ، حيث إنّ أوّل مصدر لهذه الزيارة من بين الكتب الواصلة إلينا هو كتاب (كامل الزيارة) للشيخ جعفر بن محمّد ابن قولويه قدس سره (ت ٣٦٨ هـ ق) وكتاب (مصباح المتهجد وسلاح المتعبد) لشيخ الطائفة الشيخ محمّد بن الحسن الطوسي قدس سره (ت ٤٦٠ هـ. ق) ، فإن ظاهر من جاء بعدهما أخذ رواية الزيارة منهما.
إلّا أنه ولما تشتمل عليه هذه الزيارة المباركة من إظهار للبراءة تصريحاً وتلويحاً ممن تجب البراءة منه مرت بظروف قاسية ، كان من أبرزها اختلاف النسخ وبرز ذلك بالخصوص في مصدرها الثاني أعني (مصباح المتهجد وسلاح المتعبد) فتجد بعض نسخه مشتملة على بعض الفقرات وبعضها الآخر غير مشتمل! ومن لاحظ وتتبّع الظروف التي مرّ بها الشيعة وبالخصوص شيخ الطائفة قدس سره وما لاقاه من الويلات وفتن ظهرت في زمانه وفي بغداد بالخصوص يدرك ما حصل في كتبه قدس سره من اختلاف النسخ وبالخصوص فيما يرتبط بزيارة عاشوراء ، ولا نريد أن نخوض هنا بحثاً تأريخياً حول تلك الظروف المشوبة بالخوف والحذر والتقية ، فهي بدرجة من الوضوح لمن له أدنى تتبع للتأريخ.
ولكن مع ذلك كلّه إذا رجعنا إلى نسخ الكتاب (مصباح المتهجد وسلاح المتعبد)
يتضح لنا جلياً أنّ هذه الزيارة المباركة حصل فيها حذف أو طمس لبعض مقاطعها في بعض النسخ وهي الأقل وذلك للظرف الخاص الذي عاشه الشيعة في تلك الأزمنة أعني ظرف التقية والخوف حيث إن كثيراً من نسخ الكتاب ممّا وقع في حوزتنا مشتمل على فقرات لم تكن موجودة في بعض النسخ أو هي مطموسة ، فإذا لاحظنا الظرف المتقدم ذكره ولاحظنا الفقرات التي وقع لها الحذف أو الطمس ولاحظنا النسخ المشتملة على تلك الفقرات يتضح جلياً أن ذلك وقع لظرف خاص ، وهو مما لا يكاد يخفى على من له أدنى تتبع وتدقيق.
أما ما يرتبط بنسخ كتاب (مصباح المتهجد وسلاح المتعبد) فهناك عدد كبير من النسخ لهذا الكتاب المبارك منتشرة في المكتبات العامة والخاصة ، والذي يميز بعض هذه النسخ وجود مقابلة لها مع نسخ متقدّمة عليها ، بل قد تصل المقابلة في بعض النسخ إلى نسخة المصنف ، وهذا في حد ذاته يعطي النسخة التي تمّت مقابلتها قيمة تراثية كبيرة ، ويتعامل معها كما لو كانت بخط المصنف ، وخصوصاً إذا كان المقابل لها أحد علمائنا المعروفين.
ولا يخفى أن الكلام عن نسخ «المصباح» يرتبط بالمصباح الكبير و «المصباح» الصغير وهو (مختصر «المصباح») وكلاهما من تأليف شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي قدس سره ، لفرض أن الشيخ ذكر الزيارة في كلا الكتابين واختلاف النسخ وقع في كليهما ، ويوجد عندنا نسخ لكلا الكتابين ، فعندنا عشر نسخ للمصباح الكبير وخمس نسخ للمصباح الصغير ، وتم التعرض باختصار لبحث اختلاف نسخ «المصباح» في الكتاب الذي صدر تحت إشراف مكتب آية الله العظمى الميرزا التبريزي حفظه الله تعالى (زيارة عاشوراء فوق الشبهات).
عود على بدء
هذه الزيارة المباركة واجهت مزايدات كبيرة ممن ينتسبون لهذا المذهب الحق وحصل في الآونة الأخيرة هجوم عنيف من البعض على هذه الزيارة المباركة ، وكل ذلك كان بسبب اشتمالها على أمور مرتبطة بالعقيدة الحقة وفي خصوص مسألة الولاية والبراءة لمن وممن تجب الولاية له والبراءة منه ، حيث إن هذا الأمر يثير حفائظ الطرف الآخر ولا ينسجم مع التقارب المطروح والذي يروج له نفرٌ حتى لو كان على حساب عقائدنا الثابتة ، وهذا مما يؤسف له كثيراً
وهذا ما دفعنا للبحث والمتابعة لهذه الزيارة المباركة دفاعاً وتوضيحاً لعقائدنا وثوابتنا التي لا نقبل المزايدة عليها بأي وجه من الوجوه. فبدأنا بعون الله وتوفيقه في البحث عن نسخ مصباح المتهجد وكتب أخرى ترتبط بالزيارة المباركة فحصلنا في هذه الصدد على عدد كبير من النسخ ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك فلا نعيد.
وفي الضمن وقع في حوزتنا شرح للزيارة المباركة بطبعة قديمة حجرية(١) ليس فيها أي تصحيح ولا تحقيق وهو هذا الشرح المبارك (رسالة في بيان كيفية زيارة عاشوراء ، لعلّامة عصره وأوانه المحقّق والمدقّق الكبير أبي المعالي الكلباسي قدس سره) وهو أوّل شرح للزيارة المباركة وقع في حوزتنا ، لذلك به بدأنا موسوعتنا هذا ، وهذا ما ألفت نظرنا إلى المتابعة للشروح لهذه الزيارة وبدأنا فعلاً البحث في فهارس المكتبات العامة والخاصة وبتوفيق من الله تقدست آلاؤه حصلنا على شروح كثيرة للزيارة المباركة كتبت من قبل أعلام هذه الطائفة الحقة وفيها ما هو مبسوط المقال وفيها ما هو مختصره ، وما ألفت نظرنا أن جلَّ هذه الشروح مخطوطات محفوظة في
____________________
(١) نشكر الشيخ إسماعيل ﮔﻠﺪاري على تزويدنا بصورة من هذه النسخة المحفوظة في مكتبته الخاصّة.
مكتبات عامة أو خاصة لم يطلع عليها الكثير من القراء ، وهذا ما زاد من عزمنا وتصميمنا على الشروع في هذه الموسوعة المباركة لإخراج شروح هذه الزيارة المباركة وإيصالها إلى القراء ، ليتبين للمنصفين أن هذه الزيارة كانت محط أنظار كبار علماء الطائفة ومحققيهم ، وسوف نبدأ بعون من الله وتوفيق في إخراج للشروح المبسوطة بشكل واسع واحداً تلو الآخر ثم بعد ذلك نجمع الشروح المختصرة في قسم واحد ، ثم بعد الانتهاء من ذلك كله عزمنا بعون الله وتسديده على إخراج الموسوعة في ثوب واحد وإصدار يجمع الجميع بعنوان (موسوعة زيارة عاشوراء).
وفي الختام نتقدم بالشكر الجزيل لكل من مدَّ يد العون وساهم في إنجاح هذا المشروع ، ونخصّ بالذكر مكتب آية الله العظمى الميرزا جواد التبريزي (دام ظلّه الوارف) على ما قدّمه ويقدّمه لإنجاح هذا المشروع.
وكذلك الإخوة الذين بذلوا جهوداً تحقيقية في إخراج وتحقيق هذا الشرح ، ونخص بالذكر من بينهم الأخ العزيز سماحة الشيخ إسماعيل اﻟﮕﻠﺪاري البحراني والشيخ أحمد العبيدان حفظهما الله تعالى.
نسأل الله سبحانه وتعالى بحقِّ الحُسينِ عليه السلام أن يعيننا ويسدّد خطانا لإكمال هذا المشروع الحسيني المبارك ، وأن يجعل نيّاتنا خالصة لوجهه الكريم.
إنّه خير ناصر ومعين
كتبه : يوسف أحمد الأحسائي
النصف من شعبان سنة ١٤٢٧
نبذه مختصرة
في حياة المصنّف(١)
اسمه ونسبه
العالم الرباني ، والمحقّق المتبحر ، والمتتبع الدقيق ، أسوة الورع والتقوى ، الملازم لشدة الاحتياط ، الشيخ أبو المعالي محمّد ابن محمّد إبراهيم بن محمّد حسن بن محمّد قاسم الكلباسي (الكرباسي). وينتهي نسبه الشريف إلى مالك الأشتر النخعي صاحب أمير المؤمنين عليه السلام. والكلباسي أصلها الكرباسي نسبة إلى «حوض كرباس» هرات موطن جده الحاج محمّد حسن ، وتبديل حرف الراء في الفارسية إلى اللام شائع. ولذا اختلف التعبير عن لقبه في كتب التراجم ، فمرة يسمى «الكرباسي» ومرة يسمى «الكلباسي» ، والكلّ صحيح على ما بّيّنا ، والأصحّ «الكلباسي».
مولده
ولد في مدينة أصفهان قبل طلوع الفجر بساعة ، ليلة الأربعا سابع شهر شعبان المعظم من سنة ١٢٧٤. هـ. ق ، على ما كتبه بخطه الشريف على ظهر كتاب الكشاف.
____________________
(١) سوف يأتي في خاتمة الكتاب نبذة مختصرة عن حياة المصنّف ومصنّفاته بقلمه المبارك.
نشوؤه ومعاناته
رباه العالم الرباني السيّد الممجّد الشهشهاني قدس سره ، وهو من تلاميذ والده الشيخ محمّد إبراهيم الكلباسي ، وكان عنده حتى بلغ إلى حد الإشتغال ، وتمكن من تحصيل الكمال ، فاشتغل بتعليمه حتى توفي والده العلّامة ولم يكمل له خمس عشرة سنة ، ورأى حينئذ شدائد الأمور ، ومن جملتها الإبتلاء بضيق المعيشة ، واشتغل حينها عند السيّد الجليل السيّد حسن المدرس وكان يَصِفُ حسن أخلاقه ورشاقة مذاقه من كثرة التأمل ، وأنه كان يأمر بكثرة الفكر في المسائل والتدقيق ، وأنه سمع نصيحته في ذلك فابتلى بضعف القلب ووحشة في البال على وجه لا يوصف بالمقال.
قال في خاتمة البشارات يصف تلك الحال : «ولو وصفت لك انقطاع أسباب التحصيل عني واختلال أمري في أزمنة التحصيل ، وبلغت في الوصف ما بلغت ، لكان الموصوف به أزيد وأشد بمراتب شتى ، وقد أغمضت العين عما انتقل [إلي] من الوالد الماجد من جهة الاشتغال بالتحصيل إلى أن دَرَجَ دَرْجَ الرياح ، لكن الله سبحانه قد تفضل وتصدق علي من فضله وكرمه بعد ذلك سعة في المعيشة بأسباب خارقة للعادة»(١) .
كثرة تفكره واهتمامه
كان أبو المعالي دائباً مفكراً في المطالب العلمية حتى عند الإشتغال بالأكل أو حتى في الحمام ، وكثيراً ما كان يأمر ولده بكتابة عبارة من موضع مطالعته ، سواء من عبارات نفسه أو سائر العلماء ويستصبحها في الحمام ، ويظل يفكر فيها(٢) .
____________________
(١) و (٢) وقد ذكر رحمه الله في خاتمة هذا الكتاب كلاماً مفصّلاً في ذلك.
عبادته
نقل بعض الثقات على ما في البدر التمام فقال : «كنت ليلة في منزله في خارج البلد ، فسمعت في نصف الليل صوتا غريبا تحيرت فيه ، فلما تفحصت عن حقيقة الحال وجدته صوت ولي الله غريقا في التضرع والإبتهال ، حتى إنه كرر لفظ كذلك ثلاث مرات لأدائه صحيحاً».
زهده
كان قدس سره معرضاً عن الملاذ الدنيوية بأسرها من أكلها وشربها وعزها وجاهها ، بل كان يشمئز من الجلوس في غير المواضع الدانية فضلاً عن العالية ، وكان يحب الجلوس على الأرض ، وكان يكثر الجلوس عليها خصوصاً في أيام مرضه الذي توفي فيه ، حتى كان يعوده الأعيان وهو نائم على التراب لا يرضى بالتحول عنه ، ويذكر هذا الشعر
من لم يطأ وجه التراب برجله |
وطئ التراب بصفحة الخد |
وكان جلوسه في حال دعائه ليالي الجمعة وغيرها على الأرض ، قال في بعض تحقيقاته : «المتعارف بين أفراد الإنسان الجلوس على الفرش عند التضرع إلى الله الملك المنان ، مع أن المناسب لمقام التضرع إلى رب الأرباب طريق التواضع بالجلوس على التراب».
وكان يباشر بنفسه في ليلة العاشوراء ويومها وليلة الثماني والعشرين من شهر صفر ويومها الخدمة في مجالس العزاء بنفسه.
شدة احتياطه
ينقل أنه قد وقعت أمور اضطر فيها إلى التصرف في حمام موقوف من قبل جده
العالم المؤتمن الحاج محمّد حسن ، وهو قد قرر أن يصرف وجه الإجارة في دهن السراج لطلاب بعض المدارس المخصوصة ، ولما تداول في ذلك الزمان الاستضاءة بالنفط ، فاستدعى غير واحد من الطلاب تغيير المقرر بالنفط مصراً عليه ، فما أذن بالتغيير وما رضي بالتبديل خوفا من أن يقع تغيير فيما قرره الواقف. وكذا فقد استدعى بعض أبناء السلاطين إذن التصرف في بعض الأملاك منه ، وأهدى له المبلغ الخطير ، فما أذن له في التصرف في القرى ، ولا قبل منه الهدية الكبرى ؛ نظراً إلى ما جرى من الإشكال في ثبوت الولاية العامة ، وقال : «لو أرسل إلي جميع ما في العالم لما خالفت الله سبحانه». وعلى هذا استقرت طريقته حتى انقضت مدته. وكان كثير التحرز عن الأموال المشتبهة ، ومتجنباً كل الإجتناب عن استعمال شيء من أموال أرباب الديوان في أكله وشربه ، فضلاً عما يتعلق بصلاته ووضوئه ، كما اتفق أنه أخذ لقمة يوماً ووضعها في فيه ، فظهر له أنها من تلك الأموال ، فأخرجها من فمه وألقاها وقال : «ما دخل في حلقي شيء من الأموال المشتبهة إلى الآن».
وفاته ومدفنه
توفى قدس سره في أصفهان في السابع والعشرين من صفر ١٣١٥ هـ. ق ، ودفن في بقعة مخصوصة في «تخت فولاد» وقال ولده أبو الهدى في وفاته : «وكان مرضه بلسان أهل الطب ذو سنطار الكبدي وبلسان المتعارف اسهال الدموي ، ولم يكن من زمان حدوثه إلى انتهاء مدته إلّا خمسة أيام ، ولم يظهر له في تلك الأيام القليلة أثر الموت مطلقا ، بل كان مشتغلا بالمطالعة والتصنيف في ثلاثة من تلك الأيام ، كما أنه يذكر المطالب العلمية والعملية على سبيل التفصيل مع الطبيب وغيره في يوم الآخر. ولكن ظهر في هذا اليوم من أول الصبح برودة في يديه وزاد حتى اشتد قبيل المغرب وبعده ، واجتمع عنده الأطباء في هذه الساعة ، وانقلبت حالته الشريفة من هذه الساعة ومتدرجاً ما بعدها إلى طلوع الفجر. فلمّا رأيته اشتداد الأمر ذهبت للأمر
باحضار الطبيب ، فلمّا رجعت أخبرت بما أخبرت ، واشتعل النيران في القلب بما سمعت وكان وقت وقوع هذه الداهية بعد طلوع الفجر بدقائق من يوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر صفر المظفر سنة خمسة عشر وثلاثمائة بعد الألف».
أسرته
أبوه : هو الشيخ الجليل والعالم النبيل الحاج محمّد إبراهيم الكلباسي الأصفهاني ١٢٦١ ـ ١١٨٠ هـ. ق من أعاظم علماء عصره المشاهير ، ولد في شهر ربيع الآخر عام ١١٨٠ هـ. ق في أصفهان ، وهاجر إلى العراق فأدرك الوحيد البهبهاني ، والسيّد مهدي بحر العلوم ، والشيخ كاشف الغطاء ، والسيّد على الطباطبائي صاحب الرياض ، والمقدّس الكاظمي فاشتغل عندهم ، وحضر عليهم مدة طويلة.
ثم رجع إلى إيران فحل في بلدة قم ، واشتغل بها على المحقّق الميرزا القمّي صاحب القوانين.
ثمّ سافر إلى كاشان فحضر على عالمها الشهير المولى محمّد مهدي النراقي صاحب جامع السعادات ، ثمّ عاد إلى إصفهان ، فحفّت به طبقاتها ، وألقت إليه الرئاسة أزمتها ، فإذا به مرجعها الجليل ، وزعيمها الروحي ، ورئيسها المطاع ، وقائدها الديني ، وقد نهض بأعباء العلم مع شدة الاحتياط والورع ، والتقى والصلاح ، وشغل منصة التدريس طيلة حياته وكان يؤم الناس في مسجد الحكيم ، ويرقى المنبر بعد الصلاة ، ويعظ الحضور. وكان في غاية التواضع وحسن الخلق وسلامة النفس. وكانت بينه وبين الحجة الكبير ـ معاصره ـ السيّد محمّد باقر حجة الإسلام صلة وثيقة لم تخل بها زعامة كل منهما ومرجعيته. وتوفي في اليوم الثامن من جمادى الأولى عام ١٢٦١ هـ ، وقبره بمقبرة «تخت فولاد» مزار معروف. وله تصانيف نافعة هامة في الفقه والأصول ، منها الإيقاضات أولاً ، والإشارات ثانياً ، وله أيضا رسالة الصحيح والأعم ، ورسالة تقليد الميت ، وشوارع الهداية إلى شرح
الكفاية للسبزواري ، ومنهاج الهداية ، وإرشاد المسترشدين ، والإرشاد ، والنخبة في العبادات انتخبها من الإرشاد باللغة الفارسية ، ومناسك الحج باللغة الفارسية ، ورسالة في تفطير شرب التتن كتبها لبعض أبناء السلطان فتح علي شاه القاجاري ، وقد سأله عن حكم استعمال الصائم للدخان ، وذكر فيها من أخذ عنهم العلم وعد من ذكرناهم وغيرهم. وقد تخرج على يده الكثير من العلماء والمجتهدين منهم.
أولاده : المصنف ، وولده الأكبر المجاز منه في الإجتهاد الشيخ محمّد مهدي صهر السيّد حجة الإسلام ، والآخر الشيخ جعفر. وكذا غيرهم كالميرزا الشيرازي ، والميرزا محمّد التنكابني صاحب قصص العلماء ، وصاحب الروضات ، والسيّد حسن المدرّس ، والسيّد محمّد الشهشهاني وغيرهم.
وترجم له تلميذاه في الروضات وقصص العلماء ، والسيّد حسن الصدر في التكملة ، وولده الشيخ جعفر في رسالة مستقلّة في أحوال والده ، وألّف حفيده الشيخ أبو الهدى بن أبي المعالي ابن المترجم كتابه «البدر التمام في ترجمة الوالد القمقام والجد العلام» ، وترجم له أيضا الطهراني في «الكرام البررة» ، والسيّد محسن الأمين في «أعيان الشيعة».
جدّه : وهو العالم الزاهد الحاج محمّد حسن بن محمّد قاسم الكاخكي الخراساني ، ولد في خراسان ، ومسكنه في محلة منه تعرف بحوض كرباس ، وينتهي نسبه الشريف إلى مالك الأشتر النخعي. وكان من الزاهدين في الدنيا ، والراغبين في الآخرة ، وأقام مدة في «كاخك» الذي هو من توابع «ﮔﻨﺎباد» ، وبنى فيها مدرسة ؛ وانتقل منها إلى مشهد المقدس عمَّرَ فيها المدرسة المخروبة التي في الخيابان ، وبنى خاناً في جنب المقبرة المدعوة «ﺑﻘﺘﻠﮕﺎه» ، ووقفها لصرف منافعها في المدرسة المذكورة.
وسافر منه إلى بلدة يزد ، وبنى المسجد المعروف فيها بمسجد «ريكي شبستانا».
وسافر منها إلى أصفهان ، وصحب فيه العالم المعروف محمّد البيد آبادي ، وعمَّرَ فيها المدارس المعروفة بمدرسة «الماسية» و «بماركية» و «شاهزادها». وتوفي في سنة ١١٩٠ هـ. ق ودفن في تخت فولاد.
ولده : وهو الميرزا كمال الدين أبو الهدى الكلباسي صاحب كتاب «سماء المقال» ، وهو الآخر من العلماء الكبار ، ولد في إصفهان ، وشرع في تحصيله للعلوم عند والده المصنف ، وبعد وفاة والده انتقل بصحبة أخيه جمال الدين إلى النجف ، فحضر درس المولى محمّد كاظم الخراساني صاحب الكفاية ، والسيّد محمّد كاظم اليزدي صاحب العروة ، حتى بلغ الذروة ، وحصل على درجة الإجتهاد ، وعاد بعدها إلى أصفهان ، واشتغل بالتدريس فيها. وكان له تخصص في الرجال ، وله كتب فيه وفي غيره من العلوم منها كتاب «سماء المقال» و «زلات الأقدام» في بعض الاشتباهات الرجالية ، و «الفوائد الرجالية» ، وله حاشية على الكفاية ، وكتاب في الفقه وغيره. توفي في سنة ١٣٦٥ هـ. ش ، ودفن في مقبرة والده في تخت فولاذ.
زوجته : العابدة الزاهدة بنت المرحوم السيّد زين العابدين ابن الحاج السيّد محمّد باقر حجة الإسلام الشفتي البيدآبادي.
إطراء العلماء له
١ ـ قال الشيخ عباس القمّي في الكنى والألقاب : «أبو المعالي الإصفهاني عالم ، فاضل ، متبحّر ، دقيق ، فكور ، كثير التتبع ، حسن التحرير ، كثير التصنيف ، كثير الاحتياط ، شديد الورع ، كامل النفس ، منقطع إلى العلم والعمل ، له مصنفات في الفقه والأصول والرجال»(١) ، إلى آخر ما قال.
__________________
(١) الكنى والألقاب : ١ : ١٥٩.
٢ ـ قال السيّد الأمين في أعيان الشيعة : «عالم ، عامل ، فاضل ، متجرد ، دقيق النظر ، كثير التتبع ، حسن التحرير ، كثير التصنيف ، كثير الاحتياط ، شديد الورع ، عالم رباني منقطع إلى العلم ، لا يفتر عن التحصيل ساعة ، لم يكن في عصره أشد انكباباً منه على الاشتغال» ، وذكر له ٦٥ مؤلفاً(١) .
٣ ـ وقال نجله أبو الهدى في وصفه : «إنه شمس سماء العلم والتحقيق ، وبدر فلك الفضل والتدقيق ، سلطان العلماء وتاج همتهم ، وبرهان الفقهاء ونجم أئمتهم ، خاتم المجتهدين وزبدتهم ، وقدوة المحققين وأسوتهم ، فحل الأصوليين وعمادهم ، وقريع الرجاليين وسنادهم ، الزاهد الورع ، العريف العليم ، والحبر البدل الغطريف ، العظمظم العلّامة ، فاق الأفاضل كلهم ، جمعت وأيم الله فيه مناقب.
سيماه ناطقة بنور علومه |
فجنا به فلك وهن كواكب |
المولع بافتضاض أبكار الأفكار ، والنحرير المتبحر الذي لم يظهر نظيره في الأعصار».
قال ذلك في مطلع رسالة كتبها باسم (البدر التمام في ترجمة الوالد القمقام والجد العلام) ذكر فيها لكل منهما شرحاً واسعاً عن أحوالهما وكراماتهما وقصصهما وغيرهما(٢) .
مشايخه
١ ـ العالم الجليل السيّد حسن المدرس.
٢ ـ السيّد الأمير محمّد بن عبد الصمد الحسيني الشهشهاني.
٣ ـ والأمير محمّد الصادقي.
__________________
(١) أعيان الشيعة : ٢ : ٤٣٣.
(٢) البدر التمام : ٢٥.
تلامذته
١ ـ السيّد أبو القاسم بن محمّد باقر الحسيني الدهكردي (١٢٧٢ ـ ١٣٥٣ هـ. ق).
٢ ـ الميرزا كمال الدين أبو الهدى الكلباسي صاحب «سماء المقال» ولد المصنف
٣ ـ الميرزا جمال الدين الكلباسي (١٣٥٠ هـ) ، ولد المصنف.
٤ ـ السيّد حسن بن السيّد مهدي النحوي الموسوي (١٢٨٧ ـ ١٣٦١ هـ).
٥ ـ المولى محمّد حسين بن المولى أسد الله الكرماني الأصفهاني (١٣٣٠ ـ ١٢٤٥ هـ).
٦ ـ الميرزا حسين بن إبراهيم الطباطبائي المدرس الكهنكي (١٢٨٨ ـ ١٣٧٦)
٧ ـ السيّد العلّامة الحاج حسين بن علي الطباطبائي البروجردي (١٢٩٢ ـ ١٣٨٠ هـ).
٨ ـ السيّد شهاب الدين النحوي الموسوي (١٢٦٣ ـ ١٣٤٠ هـ).
٩ ـ السيّد مهدي بن زين العابدين الموسوي الكرماني (١٣١٨ هـ).
مؤلفاته
راجع في ذلك ما سطره قدس سره بقلمه الشريف في خاتمة هذا الكتاب فقد ذكر جلّ مؤلفاته.
شرح زيارة عاشوراء
بسم الله الرحمن الرحيم
[الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين]
وبعد :
فهذه رسالة في بيان كيفية زيارة عاشوراء على من يزار بها آلاف التحية والثناء وروحي وروح العالمين له الفداء ، ولطالما كنت شائقاً إلى شرح حالها وتفصيل المقال في مجالها إلى أن ساعدني ساعد التوفيق خير رفيق من جانب الربّ الشفيق ،إِلهي ان لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي اليك في واضح الطريق؟ (١) ( قال رب اشرح لي صدري * ويسر لي أمري * واحلل عقدة من لساني )(٢) .
فشرعت في الحال في شرح الحال وتفصيل المقال مستعيناً بالله العزيز المتعال ، وباسطاً إليه كفّ السؤال أن يجعله زاد المعاد ووسيلة النوال يوم لا ينفع البنون ولا المال ، إنّه لا تخيب لديه الآمال وإليه المرجع في المبدأ والمآل.
__________________
(١) هذا مقطع من دعاء الصباح المنسوب لأمير المؤمنين عليه السلام.
(٢) طه ٢٠ : ٢٥ ـ ٢٧.
في ضبط عاشوراء ومعناها
قال في الصحاح : «ويوم عاشُوراء وعَشُورَاءَ ممدودان»(١) .
وفي القاموس : «والعاشور عاشر المحرم أو تاسعه»(٢) .
وحكى في «المصباح» في مادة تسع الخلاف في أن عاشورا تاسع المحرم أو عاشره ، إلّا أنه جعل المشهور من أقاويل العلماء سلفهم وخلفهم أنها عاشر المحرم(٣) .
وقال في مادة عشر : «وعاشوراء عاشر المحرم ، وفيها لغات المد والقصر وعشوراء بالمد»(٤) .
وقال العلّامة في المنتهى نقلاً : «يوم عاشوراء عاشر المحرم ، وبه قال المسيب والحسن البصري ، وروى عن ابن عباس أنّه التاسع من المحرم ، وليس بمعتمد لما في أحاديثنا من أنه يوم قتل الحسين عليه السلام ، ويوم قتل الحسين يوم العاشر بلا خلاف»(٥) .
__________________
(١) الصحاح : ٣ : ٧٤٧ ، مادّة «عشر».
(٢) القاموس المحيط : ٢ : ١٢٧ ، مادة «عشر».
(٣) المصباح المنير : ٧٥ ، مادّة «تسع».
وهذا نصّ عبارته : «وقوله عليه الصلاة والسلام : لأصومنّ التاسع مذهب ابن عبّاس ، وأخذ به بعض العلماء أنّ المراد بالتاسع يوم عاشوراء فعاشوراء عنده تاسع المحرّم ، والمشهور من أقاويل العلماء سلفهم وخلفهم أنّ عاشوراء عاشر المحرّم ، وتاسوعاء تاسع المحرّم».
(٤) المصباح المنير : ٤١٢ ، مادّة «عشر». وهذا نصّ عبارته : «... وعاشوراء عاشر المحرّم ، وتقدّم في تسع فيها كلام وفيها لغات المد والقصر مع الألف بعد العين ، وعشوراء بالمدّمع حذف الألف.
(٥) منتهى المطلب : ٢ : ٦١١ ، الطبعة القديمة.
والعضدي في بحث جواز نسخ التكليف بتكليف أقل منه جعل عاشورا اسماً للعشر(١) ، وهو المحكي عن آخر.
ومقتضى ما رواه الشيخ في التهذيبين(٢) بسنده عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما السلام : «أن علياً عليه السلام قال :صوموا العاشوراء : التاسع والعاشر فإنّه يكفّر ذنوب سنته؟ »(٣) عموم العاشور للتاسع والعاشر من المحرم.
وقد ظهر لك بما سمعت أنّ الظاهر أنّه لا خلاف في كون قتل الحسين سيّد الشهداء روحي وروح العالمين له الفداء في اليوم العاشر من المحرم ، ويأتي الكلام في اختصاص عاشوراء بالعاشر أو التاسع من المحرم ، وعمومها لهما ، بل نقول إن كون يوم القتل هو اليوم العاشر من قبيل الضروريات.
وقد حكى في «المجمع» في مادة عشر : «أن في حديث مناجاة موسى أنّه قال : يا ربّ ، لِمَ فضّلت أُمّة محمّد صلى الله عليه وآله على سائر الأُمم؟
فقال الله تعالى : فضّلتهم بعشر خصال.
قال موسى : وما تلك الخصال التي يعملونها حتّى آمر بني إسرائيل يعملونها؟
قال الله تعالى : الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والجمعة والجماعة والقرآن والعلم والعاشوراء.
قال موسى : يا ربّ ، وما العاشورا؟
قال : البكاء والتباكي على سبط محمّد صلى الله عليه وآله ، والمرثية والعزاء على مصيبة ولد المصطفى.
__________________
(١) الظاهر أنّه قال ذلك في شرحه على مختصر الاُصول لابن الحاجب ، والعضدي هو القاضي عبدالرحمن بن أحمد الإيجي (المتوفّى سنة ٧٥٦ هـ).
(٢) مصطلح يُطلق على كتابي الشيخ الطوسي : تهذيب الأحكام والاستبصار.
(٣) تهذيب الأحكام : ٤: ٢٩٩/١١. الاستبصار : ٢ : ١٢٤/١.
يا موسى ، ما من عبد من عبيدي في ذلك الزمان بكى أو تباكى وتعزّى على ولد المصطفى صلى الله عليه وآله إلّا وكانت له الجنة ثابتاً فيها ، وما من عبد أنفق من ماله في محبة ابن بنت نبيّه طعاماً وغير ذلك درهماً أو ديناراً إلّا وبارك له في دار الدنيا والدرهم بسبعين [درهماً] وكان معافاً(١) في الجنة وغفرت له ذنوبه.
وعزتي وجلالي ، ما من رجل أو امرأة سال دمع عينيه في يوم عاشوراء وغيره قطرة واحدة إلّا كتبت له أجر مائة شهيد»(٢) .
وأنت خبير بأن تفسير عاشورا بالبكاء والتباكي لا يوافق اللغة ولا العرف وينافي إطلاق يوم عاشوراء في آخر الحديث.
إذا عرفت ما تقدّم فنقول :
رواية ابن قولويه في كامل الزيارات
إنه روى ابن قولويه في كامل الزيارة : عن حكيم بن داود وغيره ، عن محمّد بن موسى [الهمْداني] ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة وصالح بن
__________________
(١) قوله : «وكان معافاً» ـ بالتشديد ـ من عفف بمعنى الكفّ ، كما يقال في العرف : اجعلني معافاً من هذا ، أي مكفوفاً عن استدعائه ، فهي وهذا من باب الحقيقة ، لو كان العفّة بمعنى مطلق الكفّ ، كما هو مقتضى كلام الجوهري ، أو من باب المجاز ، لو كان العفّة بمعنى الكفّ عن الحرام ، كما هو ظاهر القاموس في الحديث : «إنّ الحرام ما حرّم الله ورسوله ، ولكنّهم قد كانوا يعافون شيئاً فنحن نعافها». وربّما استدلّ على أصالة البراءة في الشبهة التحريميّة من الشبهة الحكميّة ، وهو مبنيّ على كون قوله عليه السلام : «يعافون» و «نعافها» من العفو ، لكنّه لا يساعده اللغة ، ويمكن أن يكون من عاف الرجل يعافه من باب تعب عيافة ـ بالكسر ـ أو أكرهه ، ويمكن أن يكون من عفف ، وقد حرّرنا مزيد الكلام في الاُصول. منه عفي عنه.
(٢) مجمع البحرين : مادّة «عشر».
عقبة معاً [جميعاً] ، عن علقمة بن محمّد الحضرمي ومحمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن مالك الجهني ، عن أبي جعفر [الباقر عليه السلام] ، قال : «من زار الحسين عليه السلام يوم عاشوراء حتى يظلّ عنده باكياً لقى الله عزّ وجلّ يوم القيامة بثواب ألفي ألف حجّة ، وألفي ألف عمرة ، وألفي ألف غزوة , وثواب كلّ حجّة وعمرة وغزوة كثواب من [حج] واعتمر وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومع الأئمة الراشدين عليهم السلام.
قال : قلت : جعلت فداك ، فما لمن كان في بعيد البلاد وأقاصيها ولم يمكنه المصير إليه في ذلك اليوم؟
قال : إذا كان ذلك اليوم برز إلى الصحراء أو صعد سطحاً مرتفعاً في داره ، وأومى إليه بالسلام ، واجتهد على قاتله بالدعاء ، وصلّى بعده(١) ركعتين يفعل ذلك في صدر النهار قبل الزوال ، ثمّ ليندب الحسين عليه السلام ويبكيه ، ويأمر من في داره ممن لا يتقيه بالبكاء عليه ، ويقيم في داره المصيبة [مصيبته] بإظهار الجزع عليه ويتلاقون بالبكاء بعضهم بعضاً [في البيوت وليعزّ بعضهم بعضاً] بمصاب الحسين عليه السلام ، فأنا ضامن لهم إذا فعلوا ذلك على الله عزّ وجلّ جميع هذا الثواب.
فقلت : جعلت فداك ، وأنت الضامن لهم إذا فعلوا ذلك والزعيم به؟
قال :أنا الضامن لهم ذلك والزعيم لمن فعل ذلك.
قال : قلت : جعلت فداك ، فكيف يعزّي بعضهم بعضاً؟
قال :يقولون : عظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام ، وجعلنا وإيّاكم من الطالبين بثأره مع وليّه الإمام المهدي من آل محمّد صلى الله عليه وآله ، فإن استطعت أن لا تنتشر يومك في حاجة فافعل ، فإنّه يوم نحسٍ لا يقضى فيه حاجة [مؤمن] وإن قضيت لم يبارك له فيها ولم يرَ رشداً ، ولا تدّخرن لمنزلك شيئاً ، فإنّه من ادّخر لمنزله شيئاً في ذلك اليوم
__________________
(١) قوله : «بعده» هكذا فيما نقل في بحار الأنوار وغيره ، لكنّه في النسخة التي عندي من كامل الزيارة : «بعده» بدون الهاء. منه عفي عنه.
لم يبارك له فيما يدّخره ولا يبارك له في أهله ، فمن فعل ذلك كتب له ثواب ألف ألف حجة وألف وألف عمرة وألف ألف غزوة كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله ، وكان له ثواب مصيبة كل نبّي ورسول وصديق وشهيد مات أو قتل منذ خلق الله الدنيا إلى أن تقوم الساعة.
قال صالح بن عقبة وسيف بن عميرة : قال علقمة بن محمّد الحضرمي : فقلت لأبي جعفر عليه السلام : علّمني دعاء أدعو به في ذلك اليوم إذا أنا زرته من قريب ودعاء أدعوا به إذا لم أزره من قريب وأومأت إليه من بعد البلاد ومن [سطح] داري؟
قال فقال :يا علقمة ، إذا أنت صلّيت الركعتين بعد أن تومئ إليه بالسلام وقلت عند الإيماء إليه بعد الركعتين هذا القول ، فإنّك إذا قلت ذلك فقد دعوت بما يدعو به من زاره من الملائكة ، وكتب الله لك بها ألف ألف حسنة ، ومحى عنك ألف ألف سيئة ، ورفع لك مائة ألف ألف درجة ، وكنت كمن استشهد مع الحسين عليه السلام تشاركهم في درجاتهم ولا تُعرف إلّا في الشهداء الذين استشهدوا معه وكتب لك ثواب [زيارة] كلّ نبّي ورسول زيارة كل من زار الحسين بن عليّ عليهما السلام منذ يوم قتل صلوات الله عليه
تقول :
السَّلَامُ عَلَيْكَ يا أَبا عَبْدِاللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يابْنَ رَسُولِ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يا خِيَرَةَ اللهِ وَابْنَ خِيَرَتِهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يابْنَ أَميرِ الْمُؤْمِنينَ وَابْنَ سَيِّدِ الْوَصيّينَ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَابْنَ فاطِمَةَ سَيِّدَةِ نِساءِ الْعالَمينَ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يا ثارَ اللهِ وَابْنَ ثارِهِ وَالْوِتْرَ الْمَوْتُورَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى الْأَرْواحِ الَّتي حَلَّتْ بِفِنائِكَ ، [وَأَناخَتْ بِرَحْلِكَ ،] عَلَيْكُمْ مِنّي جَميعاً سَلامُ اللهِ أَبَداً ما بَقيتُ وَبَقِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ.
يا أَبا عَبْدِاللهِ ، لَقَدْ عَظُمَتِ الرَّزِيَّةُ ، وَجَلَّتِ الْمُصيبَةُ بِكَ عَلَيْنا وَعَلىٰ جَميعِ أَهْلِ السَّمٰواتِ ، فَلَعَنَ اللهُ اُمَّةً أَسَّسَتْ أَساسَ الظُّلْمِ وَالْجَوْرِ عَلَيْكُمْ أَهْلَ
الْبَيْتِ ، وَلَعَنَ اللهُ اُمَّةً دَفَعَتْكُمْ عَنْ مَقامِكُمْ ، وَأَزالَتْكُمْ عَنْ مَراتِبِكُمُ الَّتي رَتَّبَكُمُ اللهُ فيها، وَلَعَنَ اللهُ اُمَّةً قَتَلَتْكَ (١) ،وَلَعَنَ اللهُ الْمُمَهِّدينَ لَهُمْ بِالتَّمْكينِ مِنْ قِتالِكُمْ.
يا أَبا عَبْدِاللهِ ، إِنّي سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَكُمْ ، وَحَرْبٌ لِمَنْ حارَبَكُمْ إِلىٰ يَوْمِ الْقِيامَةِ ، فَلَعَنَ اللهُ آلَ زِيادٍ وَآلَ مَرْوانَ ، وَلَعَنَ اللهُ بَني اُمَيَّةَ قاطِبَةً ، وَلَعَنَ اللهُ ابْنَ مَرْجانَةَ ، وَلَعَنَ اللهُ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ ، وَلَعَنَ اللهُ شِمْراً ، وَلَعَنَ اللهُ اُمَّةً أَسْرَجَتْ وَأَلْجَمَتْ وَتَهَيَّأَتْ لِقِتالِكَ.
يا أَبا عَبْدِاللهِ ، بِأَبي أَنْتَ وَاُمّي ، لَقَدْ عَظُمَ مُصابي بِكَ ، فَأَسْأَلُ اللهَ الَّذي أَكْرَمَ مَقامَكَ أَنْ يُكْرِمَني بِكَ ، وَيَرْزُقَني طَلَبَ ثارِكَ مَعَ إِمامٍ مَنْصُورٍ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ.
اللـهُمَّ اجْعَلْني وَجيهاً بِالْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلامُ عِنْدَكَ في الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ.ٰ
يا سَيِّدي يا أَبا عَبْدِاللهِ ، إِنّي أَتَقَرَّبُ إِلى اللهِ ، وَإِلىٰ رَسُولِهِ ، وَإِلىٰ أَميرِ الْمُؤْمِنينَ ، وَإِلىٰ فاطِمَةَ ، وَإِلَى الْحَسَنِ ، وَإِلَيْكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ بِمُوالاتِكَ ، وَبِالْبَراءَةِ مِمَّنْ قاتَلَكَ ، وَنَصَبَ لَكَ الْحَرْبَ ، وَمِنْ جَميعِ أَعْدائِكُمْ ، وَبِالْبَراءةِ مِمَّنْ أَسَّسَ أَساسَ الْجَوْرِ وَبَنىٰ عَلَيْهِ بُنْيانَهُ ، وَأَجْرىٰ ظُلْمَهُ وَجَوْرَهُ عَلَيْكُمْ وَعَلىٰ أَشْياعِكُمْ ، بَرِئْتُ إِلَى اللهِ وَإِلَيْكُمْ مِنْهُمْ ، وَأَتَقَرَّبُ إِلَى اللهِ ، ثُمَّ إِلَيْكُمْ بِمُوالاتِكُمْ ، وَمُوالاةِ وَلِيِّكُمْ ، وَبِالْبَراءَةِ مِنْ أَعْدائِكُمْ ، وَمِنَ النّاصِبينَ لَكُمُ
__________________
(١) قوله : «قَتَلَتْكَ » هكذا في النسخة التي عندي من كامل الزيارة ، وفيما نقله عنه في بحار الأنوار كذلك ، لكن فيما نقل عنه بعض : «قَتَلَتْكُمْ» ، وهو الأوفق بالسياق ، منه عفي عنه.
الْحَرْبَ ، وَالْبَراءَةِ مِنْ أَشْياعِهِمْ وَأَتْباعِهِمْ.
إِنّي سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَكُمْ ، وَحَرْبٌ لِمَنْ حارَبَكُمْ ، مُوالٍ لِمَنْ والاكُمْ ، وَعَدُوٌّ لِمَنْ عاداكُمْ ، فَأَسْأَلُ اللهَ الَّذي أَكْرَمَني بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَةِ أَوْلِيائِكُمْ ، وَرَزَقَني الْبَراءَةَ مِنْ أَعْدائِكُمْ ، أَنْ يَجْعَلَني مَعَكُمْ في الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ ، وَأَنْ يُثَبِّتَ لي عِنْدَكُمْ قَدَمَ صِدْقٍ في الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ.
وَأَسْأَلُهُ أَنْ يُبَلِّغَني الْمَقامَ الَْمَحْمُودَ لَكُمْ عِنْدَ اللهِ ، وَأَنْ يَرْزُقَني طَلَبَ ثارِكُمْ مَعَ إِمامٍ مَهْديٍّ ناطِقٍ لَكُمْ ، وَأَسْأَلُ اللهَ بِحَقِّكُمْ وَبِالشَّأْنِ الَّذي لَكُمْ عِنْدَهُ أَنْ يُعْطِيَني بِمُصابي بِكُمْ أَفْضَلَ ما يُعْطي مُصاباً بِمُصيبَتِهِ ، أَقُولُ إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ، يا لَها مِنْ مُصيبَةٍ ما أَعْظَمَها وَأَعْظَمَ رَزِيَّتَها في الْإِسْلامِ وَفي جَميعِ السَّمٰواتِ وَالْأَرْضِ.
اللّـهُمَّ اجْعَلْني في مَقامي هٰذا مِمَّنْ تَنالُهُ مِنْكَ صَلَواتٌ وَرَحْمَةٌ وَمَغْفِرَةٌ.
اللّـهُمَّ اجْعَلْ مَحْيايَ مَحْيا مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَمَماتي مَماتَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ.
اللّـهُمَّ اِنَّ هٰذا يَوْمٌ تَنَزَّلَتْ فيهِ اللَّعْنَةُ عَلىٰ آلِ زِيادٍ ، وَآلِ اُمَيَّةَ ، وَابْنِ آكِلَةِ الْأَكْبادِ ، اللَّعينِ ابْنِ اللَّعينِ عَلىٰ لِسانِ نَبِيِّكَ في كُلِّ مَوْطِنٍ وَمَوْقِفٍ وَقَفَ فيهِ نَبيُّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ.
اللّـهُمَّ الْعَنْ أَبا سُفْيانَ وَمُعاوِيَةَ(١) وَعَلىٰ يَزيدَ بْنَ مُعاوِيَةَ اللَّعْنَةُ أَبَدَ الْآبِدينَ ،
__________________
(١) وفي زاد المعاد : «وَمُعاوِيَةَ بْنَ أَبي سُفْيانَ » ، منه رحمه الله.
اللّـهُمَّ فَضاعِفْ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةَ أَبَداً لِقَتْلِهِمُ الْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.
اللّـهُمَّ إِنّي أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ في هٰذَا الْيَوْمِ ، وَفي مَوْقِفي هٰذا ، وَأَيّامِ حَياتي بِالْبَراءَةِ مِنْهُمْ بِاللَّعْنِ عَلَيْهِمْ ، وَبِالْمُوالاةِ لِنَبِيِّكَ وَأَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ.
ثمّ تقول مائة مرّة :
اللّـهُمَّ الْعَنْ أَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلىٰ ذلِكَ.
اللّـهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتي حارَبَتِ الْحُسَيْنَ وَشايَعَتْ وَبايَعَتْ عَلىٰ قَتْلِهِ وَقَتْلِ أَنْصارِهِ ، اللّـهُمَّ الْعَنْهُمْ جَميعاً.
ثمّ تقول مائة مرّة :
السَّلَامُ عَلَيْكَ يا أَبا عَبْدِاللهِ وَعلَى الْأَرْواحِ الَّتي حَلَّتْ بِفِنائِكَ ، وَأَناخَتْ بِرَحْلِكَ ، عَلَيْكُمْ مِنّي جَميعاً سَلامُ اللهِ أَبَداً ما بَقيتُ وَبَقِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ ، وَلا يَجْعَلَهُ اللهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِن زِيارَتِكُمْ.
السَّلَامُ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، وَأَصْحابِ الْحُسَينِ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعينَ.
ثمّ تقول مرّة واحدة :
اللّـهُمَّ خُصَّ أَنْتَ أَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ آلَ نَبِيِّكَ بِاللَّعْنِ ، ثُمَّ الْعَنْ أَعْداءَ آلِ مُحَمَّدٍ مِنَ الْأَوَّلينَ وَالْآخِرينَ ، اللّـهُمَّ الْعَنْ يَزيدَ وأَباهُ ، وَالْعَنْ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيادٍ وَآلَ مَرْوانَ وَبَني اُمَيَّةَ قاطِبَةً إِلىٰ يَوْمِ الْقِيامَةِ.
ثمّ تسجد سجدة تقول فيها :
اللّـهمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدَ الشّاكِرينَ عَلىٰ مُصابِهِمْ. الْحَمْدُ لِلّهِ عَلىٰ عَظيمِ رَزِيَّتي فِيهِمْ ، اللّـهُمَّ ارْزُقْني شَفاعَةَ الْحُسَيْنِ يَوْمَ الْوُرُودِ ، وَثَبِّتْ لي قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَيْنِ وَأَصْحابِ الْحُسَيْنِ الَّذينَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ الْحُسَيْنِ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ.
قال : يا علقمة ، إن استطعت أن تزوره في كلّ يوم بهذه الزيارة من دهرك فافعل ، فلك ثواب جميع ذلك إن شاء الله تعالى»(١) .
رواية الشيخ في مصباح المتهجد
وروى الشيخ في «المصباح» ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «من زار الحسين بن عليّ عليهما السلام في يوم عاشوراء من المحرّم حتّى يظلّ عنده باكياً لقي الله عزّ وجلّ يوم يلقاه بثواب ألفي حجّة ، وألفي عمرة ، وألفي غزوة ، ثواب كلّ غزوة وحجّة وعمرة كثواب من حجّ واعتمر وغزى مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومع الأئمّة الراشدين عليهم السلام.
قال : قلت : جعلت فداك ، فما لمن كان في بعيد البلاد وأقاصيه ولم يمكنه المصير إليه في ذلك اليوم؟
قال :إذا كان كذلك برز إلى الصحراء ، أو صعد سطحاً مرتفعاً في داره ، وأومأ إليه بالسلام ، واجتهد في الدعاء على قتليه ، وصلّى من بعد ركعتين ، وليكن ذلك في صدر النهار قبل أن تزول الشمس ، ثمّ ليندب الحسين عليه السلام ويبكيه ، ويأمر من في داره ممن لا يتقيه بالبكاء عليه ، ويقيم في داره المصيبة بإظهار الجزع عليه ، وليعزّ بعضهم
__________________
(١) كامل الزيارات : ٣٢٥ ، الباب ٧١ ثواب من زار الحسين عليه السلام يوم عاشوراء ، الحديث ٩.
بعضاً بمصابهم بالحسين عليه السلام ، فأنا ضامن لهم إذا فعلوا ذلك على الله تعالى جميع ذلك
قلت : جعلت فداك ، أنت الضامن لذلك لهم والزعيم؟
قال :أنا الضامن وأنا الزعيم لمن فعل ذلك.
قلت : فكيف يعزي بعضنا بعضاً؟
قال :تقولون : أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام ، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمّد عليهم السلام ، وإن استطعت أن لا تنتشر يومك في حاجة فافعل فإنه يومُ نحسٍ لا تقضى فيه حاجة مؤمن ، وإن قضيت لم يبارك له فيها ولم ير فيها رشداً ، ولا يدّخرون أحدكم لمنزله فيه شيئاً ، فمن ادخر في ذلك اليوم شيئاً لم يبارك له فيما ادخر ولم يبارك له في أهله ، فإذا فعلوا ذلك كتب الله لهم ثواب ألف حجة وألف عمرة وألف غزوةكلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله ، وكان له أجر وثواب مصيبة كلّ نبيّ ورسول ووصي وصديق وشهيد مات أو قتل منذ خلق الله الدنيا إلى أن تقوم الساعة.
قال صالح بن عقبة وسيف بن عميرة : قال علقمة بن محمّد الحضرمي : قلت لأبي جعفر عليه السلام : علّمني دعاء أدعو به ذلك اليوم إذا أنا زرته من قرب ، ودعاء أدعو به أذا لم أزه من قرب ، وأومأت من بعد البلاد ومن داري بالسلام إليه.
قال : فقال لي :يا علقمة ، إذا أنت صلّيت الركعتين بعد أن تومي إليه بالسلام فقل بعد الإيماء إليه من بعد التكبير هذا القول فإنّك إذا قلت ذلك فقد دعوت بما يدعو به زوّاره من الملائكة ، وكتب الله لك مائة ألف ألف درجة ، وكنت كمن استشهد مع الحسين عليه السلام حتّى تشاركهم في درجاتهم ولا تعرف إلّا في الشهداء الذين استشهدوا معه ، وكتب لك ثواب زيارة كل نبيّ وكل رسول وزيارة كل من زار الحسين عليه السلام منذ يوم قتل عليه السلام.
تقول : السَّلامُ عَلَيْكَ يا أَبا عَبْدِاللهِ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يابْنَ رَسُولِ اللهِ ، السَّلامُ عَلَيْكَ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يابْنَ أَميرِ الْمُؤْمِنينَ ، وَابْنَ سَيِّدِ الْوَصيّينَ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَابْنَ فاطِمَةَ سَيِّدَةِ نِساءِ الْعالَمينَ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا ثارَ اللهِ وَابْنَ ثارِهِ وَالْوِتْرَ الْمَوْتُورَ، السَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَى الْأَرْواحِ الَّتي حَلَّتْ بِفِنائِكَ ، [وَأَناخَتْ بِرَحْلِكَ ،] عَلَيْكُمْ مِنّي جَميعاً سَلامُ اللهِ أَبَداً ما بَقيتُ وَبَقِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ.
يا أَبا عَبْدِاللهِ ، لَقَدْ عَظُمَتِ الرَّزِيَّةُ ، وَجَلَّتْ وعَظُمَتْ مُصيبَتُكَ في السَّمٰواتِ عَلىٰ جَميعِ أَهْلِ السَّمٰواتِ ، فَلَعَنَ اللهُ اُمَّةً أَسَّسَتْ أَساسَ الظُّلْمِ وَالْجَوْرِ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ، وَلَعَنَ اللهُ اُمَّةً دَفَعَتْكُمْ عَنْ مَقامِكُمْ وَأَزالَتْكُمْ عَنْ مَراتِبِكُمُ الَّتي رَتَّبَكُمُ اللهُ فيها، وَلَعَنَ اللهُ اُمَّةً قَتَلَتْكُمْ ، وَلَعَنَ اللهُ الْمُمَهِّدينَ لَهُمْ بِالتَّمْكينِ مِنْ قِتالِكُمْ ، بَرِئْتُ إِلى اللهِ وَإِلَيْكُمْ مِنْهُمْ وَمِنْ أَشْياعِهِمْ وَأَتْباعِهِمْ وَأَوْلِيائِهِمْ.
يا أَبا عَبْدِاللهِ ، إِنّي سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَكُمْ ، وَحَرْبٌ لِمَنْ حارَبَكُمْ إِلىٰ يَوْمِ الْقِيامَةِ ، وَلَعَنَ اللهُ آلَ زِيادٍ وَآلَ مَرْوانَ ، وَلَعَنَ اللهُ بَني اُمَيَّةَ قاطِبَةً ، وَلَعَنَ اللهُ ابْنَ مَرْجانَةَ ، وَلَعَنَ اللهُ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ ، وَلَعَنَ اللهُ شِمْراً ، وَلَعَنَ اللهُ اُمَّةً أَسْرَجَتْ وَأَلْجَمَتْ وَتَنَقَّبَتْ لِقِتالِكَ.
بِأَبي أَنْتَ وَاُمّي لَقَدْ عَظُمَ مُصابي بِكَ فَأَسْأَلُ اللهَ الَّذي أَكْرَمَ مَقامَكَ ، وَأَكْرَمَني بِكَ أَنْ يَرْزُقَني طَلَبَ ثارِكَ مَعَ إِمامٍ مَنْصُورٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، اللّـهُمَّ اجْعَلْني عِنْدَكَ وَجيهاً بِالْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلامُ في الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ.
يا أَبا عَبْدِاللهِ ، إِنّي أَتَقَرَّبُ إِلى اللهِ ، وَإِلىٰ رَسُولِهِ ، وَإِلىٰ أَميرِ الْمُؤْمِنينَ ، وَإِلىٰ فاطِمَةَ ، وَإِلَى الحَسَنِ ، وَإِلَيْكَ بِمُوالاتِكَ ، وَبِالْبَراءَةِ مِمَّنْ قاتَلَكَ وَنَصَبَ لَكَ الْحَرْبَ ، وَبِالْبَراءَةِ مِمَّنْ أَسَّسَ أَساسَ الظُّلْمِ وَالْجَوْرِ عَلَيْكُمْ ، وَأَبْرَأُ إِلَى اللهِ وإِلى رَسُولِهِ مِمَّنْ أَسَّسَ أَساسَ ذلِكَ وَبَنىٰ عَلَيْهِ بُنْيانَهُ ، وَجَرىٰ في ظُلْمِهِ وَجَوْرِهِ عَلَيْكُمْ وَعَلىٰ أَشْياعِكُمْ ، بَرِئْتُ إِلَى اللهِ وَإِلَيْكُمْ مِنْهُمْ ، وَأَتَقَرَّبُ إِلَى اللهِ ، ثُمَّ إِلَيْكُمْ بِمُوالاتِكُمْ ، وَمُوالاةِ وَلِيِّكُمْ ، وَبِالْبَراءَةِ مِنْ أَعْدائِكُمْ ، وَالنّاصِبينَ لَكُمُ الْحَرْبَ ، وَبِالْبَراءَةِ مِنْ أَشْياعِهِمْ وَأَتْباعِهِمْ.
إِنّي سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَكُمْ ، وَحَرْبٌ لِمَنْ حارَبَكُمْ ، وَوَلِيٌّ لِمَنْ والاكُمْ ، وَعَدُوٌّ لِمَنْ عاداكُمْ ، فَأَسْأَلُ اللهَ الَّذي أَكْرَمَني بِمَعْرِفَتِكُمْ ، وَمَعْرِفَةِ أَوْلِيائِكُمْ ، وَرَزَقَني الْبَراءَةَ مِنْ أَعْدائِكُمْ ، أَنْ يَجْعَلَني مَعَكُمْ في الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ ، وَأَنْ يُثَبِّتَ لي عِنْدَكُمْ قَدَمَ صِدْقٍ في الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ ، وَأَسْأَلُهُ أَنْ يُبَلِّغَني الْمَقامَ الَْمَحْمُودَ لَكُمْ عِنْدَ اللهِ ، وَأَنْ يَرْزُقَني طَلَبَ ثارِكُمْ مَعَ إِمامِ هُدىً ظاهِرٍناطِقٍ بِالْحَقِّ مِنْكُمْ ، وَأَسْأَلُ اللهَ بِحَقِّكُمْ وَبِالشَّأْنِ الَّذي لَكُمْ عِنْدَهُ أَنْ يُعْطِيَني بِمُصابي بِكُمْ أَفْضَلَ ما يُعْطي مُصاباً بِمُصيبَتِهِ ، مُصيبَةً ما أَعْظَمَها وَأَعْظَمَ رَزِيَّتَها في الْإِسْلامِ وَفي جَميعِ أَهْلِ السَّمٰواتِ وَالْأَرْضِ.
اللّـهُمَّ اجْعَلْني في مَقامي هٰذا مِمَّنْ تَنالُهُ مِنْكَ صَلَواتٌ وَرَحْمَةٌ وَمَغْفِرَةٌ.
اللّـهُمَّ اجْعَلْ مَحْيايَ مَحْيا مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَمَماتي مَماتَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ.
اللّـهُمَّ إِنَّ هٰذا يَوْمٌ تَبَرَّكَتْ بِهِ بَنُو اُمَيَّةَ وَابْنُ آكِلَةِ الْأَكْبادِ ، اللَّعينُ ابْنُ اللَّعينِ ،
عَلىٰ لِسانِكَ وَلِسانِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ في كُلِّ مَوْطِنٍ وَمَوْقِفٍ وَقَفَ فيهِ نَبيُّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ.
اللّـهُمَّ الْعَنْ أَبا سُفْيانَ وَمُعاوِيَةَ وَيَزيدَ بْنَ مُعاوِيَةَ عَلَيْهِمْ مِنْكَ اللَّعْنَةُ أَبَدَ الْآبِدينَ ، وَهٰذا يَوْمٌ فَرِحَتْ بِهِ آلُ زيادٍ وَآلُ مَرْوانَ بِقَتْلِهِمُ الْحُسَيْنَ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ ، اللّـهُمَّ فَضاعِفْ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَ مِنْكَ وَالْعَذابَ الْأَليمَ.
اللّـهُمَّ إِنّي أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ في هٰذَا الْيَوْمِ ، وَفي مَوْقِفي هٰذا ، وَأَيّامِ حَياتي بِالْبَراءَةِ مِنْهُمْ ، وَاللَّعْنَةِ عَلَيْهِمْ ، وَبِالْمُوالاةِ لِنَبِيِّكَ وَآلِ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلامُ.
ثمّ تقول :
اللّـهُمَّ الْعَنْ أَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلىٰ ذلِكَ.
اللّـهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتي جاهَدَتِ الْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلامُ ، وَشايَعَتْ وَبايَعَتْ وَتابَعَتْ عَلىٰ قَتْلِهِ ، اللّـهُمَّ الْعَنْهُمْ جَميعاً. تقول ذلك مائة مرّة.
ثمّ تقول :
السَّلامُ عَلَيْكَ يا أَبا عَبْدِاللهِ وَعلَى الْأَرْواحِ الَّتي حَلَّتْ بِفِنائِكَ ، عَلَيْكَ مِنّي سَلامُ اللهِ أَبَداً ما بَقيتُ وَبَقِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ ، وَلا جَعَلَهُ اللهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّي لِزِيارَتِكُمْ.
السَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ ، وَعَلىٰ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، وَعلىٰ أَوْلادِ الْحُسَيْنِ ، وَعَلىٰ أَصْحابِ الْحُسَينِ. تقول ذلك مائة مرّة.
ثمّ تقول :
اللّـهُمَّ خُصَّ أَنْتَ أَوَّلَ ظالِمٍ بِاللَّعْنِ مِنّي ، وَابْدَأْ بِهِ أَوَّلاً ، ثُمَّ الْعَنِ الثّاني وَالثّالِثَ وَالرّابِعَ. اللّـهُمَّ الْعَنْ يَزيدَ خامِساً ، وَالْعَنْ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيادٍ وَابْنَ مَرْجانَةَ وَعُمَرَ بْنَ سَعْدٍ وَشِمْراً وَآلَ أَبي سُفْيانَ وَآلَ زِيادٍ وَآلَ مَرْوانَ إِلىٰ يَوْمِ الْقِيامَةِ.
ثمّ تسجد وتقول :
اللّـهمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدَ الشّاكِرينَ عَلىٰ مُصابِهِمْ ، الْحَمْدُ لِلّهِ عَلىٰ عَظيمِ رَزِيَّتي ، اللّـهُمَّ ارْزُقْني شَفاعَةَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلامُ يَوْمَ الْوُرُودِ ، وَثَبِّتْ لي قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَيْنِ وَأَصْحابِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلامُ الَّذينَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلامُ.
قال علقمة : قال أبو جعفر عليه السلام :إن استطعت أن تزوره في كل يوم بهذه الزيارة من دارك فافعل ، ولك ثواب جميع ذلك .»(١) .
وقد روى في الوسائل هذه الرواية عن «المصباح» أيضاً ، لكن برواية صالح بن عقبة ، عن علقمة ، عن أبي جعفر عليه السلام.
فالراوي عن أبي جعفر عليه السلام هو علقمة(٢) ، وهو مقتضى ما يأتي من نقل السيّد
__________________
(١) مصباح المتهجّد وسلاح المتعبّد : ٧٧٢.
(٢) وسائل الشيعة : ١٤ : ٤٩٤ ، الباب ٦٣ من أبواب المزار وما يناسبه ، الحديث ٣.
ولا يخفى أنّ صاحب الوسائل أورد مقطعين من الزيارة المباركة في كتابه : أحدهما في المورد آنف الذكر ، وثانيهما : في الباب ٥٥ من أبواب المزار ، الحديث ٥.
والملاحظ أنّه في المورد الأوّل قال : محمّد بن الحسن في المصباح ، عن محمّد بن»
الداماد(١) تلك الرواية في رسالته المعمولة في آداب أيام أربعة(٢) .
رواية أخرى رواها الشيخ في «المصباح»(٣)
وروى الشيخ في «المصباح» أيضاً ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، قال : «خرجت مع صفوان بن مهران الجمّال وجماعة من أصحابنا إلى الغريّ بعد ما خرج أبو عبد الله الصادق عليه السلام ، فسرنا من الحيرة(٤) إلى المدينة ،
__________________
«إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن علقمة ، عن أبي جعفر عليه السلام.
وفي المورد الثاني قال : وعن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام. ففي المورد الأوّل ذكر الراوي عن صالح بن عقبة: علقمة ، وفي المورد الثاني جعل الراوي عنه أبيه.
(١) ترجمة مختصرة للسيّد الداماد: هو السيّد محمّد باقر بن شمس الدين محمّد الحسيني الأسترآبادي الأصل ، الأصفهاني المنشأ والموطن ، المعروف بـ (الميرداماد) ، الملقّب بـ (المعلّم الثالث) ، من أعلام القرن الحادي عشر ، ومن كبار مؤلّفي الشيعة ، ترجم له كثير من العلماء وأثنوا عليه ، وكان معاصراً للشيخ البهائي وله به علاقة خاصّة ، ووجه اشتهاره بـ (الميرداماد) هو أنّ والده السيّد محمّد الأسترآبادي لمّا تزوّج بنت الشيخ عليّ (المحقّق الثاني) الكركي ، اشتهر هذا السيّد بالداماد ، ثمّ لمّا تولّد من بنت المحقّق الكركي السيّد محمّد باقر اشتهر كما اشتهر والده بالداماد.
توفّي سنة ١٠٤١ هـ. ق ، ودفن في النجف الأشرف ، وكان من أبرز تلامذته: الحكيم الإلهٰي ، والفيلسوف الرّباني صدر الدين الشيرازي ، المعروف بـ (ملّا صدرا) ، وله مصنّفات كثيرة تفوق السبعين مصنّفاً.
(٢) ستأتي الإشارة إلى هذه الرسالة للمحقّق الداماد.
(٣) لا يخفى أنّ الشيخ في المصباح ذكر هذه الرواية في ذيل الرواية السابقة بلا فاصلة ، حيث قال : «وروى محمّد بن خالد الطيالسي الخ».
(٤) الحيرة ـ بالكسر ـ: مدينة قرب الكوفة ، كما ذكره في الصحاح. منه عفي عنه.
فلمّا فرغنا من الزيارة صرف صفوان وجهه إلى ناحية أبي عبد الله عليه السلام فقال لنا :تزورون الحسين عليه السلام من هذا المكان من عند رأس أمير المؤمنين عليه السلام من هاهنا ، وأومأ إليه أبو عبد الله الصادق عليه السلام وأنا معه.
قال : فدعا صفوان بالزيارة التي رواها علقمة بن محمّد الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام في يوم عاشوراء ، ثمّ صلّى ركعتين عند رأس أمير المؤمنين عليه السلام ، وودّع في دبرها أمير المؤمنين عليه السلام ، وأومأ إلى الحسين عليه السلام بالتسليم منصرفاً وجهه نحوه ، فودّع فكان فيما دعاه في دبرهما :
يا اللهُ يا اللهُ يا اللهُ ، يا مُجِيبَ دَعوَةِ الْمُضْطَرِّينَ ، يا كاشِفَ كُرَبِ الْمَكْرُوبِينَ ، يا غِياثَ الْمُسْتَغِيثِينَ ، يا صَرِيخَ الْمُسْتَصْرِخِينَ ، وَيا مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَيَّ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ، يا مَنْ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ، وَيا مَنْ هُوَ بِالْمَنْظَرِ الْأعْلىٰ ، وَبِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ، وَيا مَنْ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوىٰ ، وَيا مَنْ يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَما تُخْفي الصُّدُورُ ، يا مَنْ لَا يَخْفىٰ عَلَيْهِ خافِيَةٌ ، وَيا مَنْ لَا تَشْتَبِهُ عَلَيْهِ الْأَصْواتُ ، وَيا مَنْ لَا تُغَلِّطُهُ الْحاجاتُ ، وَيا مَنْ لَا يُبْرِمُهُ إِلْحاحُ الْمُلِحِّينَ ، يا مُدْرِكَ كُلِّ فَوْتٍ ، وَيا جامِعَ كُلِّ شَمْلٍ ، وَيا بَارِئَ النُّفُوسِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، يا مَنْ هُوَ كُلَّ يَوْمٍ في شَأْنٍ ، يا قاضِيَ الْحاجاتِ ، يا مُنَفِّسَ الْكُرُباتِ ، يا مُعْطِيَ السُّؤُلَاتِ ، يا وَلِيَّ الرَّغَباتِ ، يا كافِيَ الْمُهمّاتِ ، يا مَنْ يَكْفي مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يَكْفي مِنْهُ شَيْءٌ في السَّمٰواتِ وَالْأََرْضِ.
أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ خاتَمِ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، وَعَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤمِنِينَ ، وَبِحَقِّ فَاطِمَةَ بِنْتِ نَبيِِّكَ ، وَبِحَقِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ، فَإِنّي بِهِمْ أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ في مَقامي هٰذا ، وَبِهِمْ أَتَوَسَّلُ ، وَبِهِمْ أَسْتَشْفِعُ إِلَيْكَ ، وَبِحَقِّهِمْ
أَسْأَلُكَ وَاُقْسِمُ وَأَعْزِمُ عَلَيْكَ ، وَبِالشَّأْنِ الَّذي لَهُمْ عِنْدَكَ وَبِالْقَدْرِ الَّذي لَهُمْ عِنْدَكَ ، وَبِالَّذي فَضَّلْتَهُمْ عَلَى الْعالَمِينَ ، وَبِاسْمِكَ الَّذي جَعَلْتَهُ عِنْدَهُمْ ، وَبِهِ خَصَصْتَهُمْ دُونَ الْعالَمِينَ ، وَبِهِ أَبَنْتَهُمْ وَأَبَنْتَ فَضْلَهُمْ مِنْ فَضْلِ الْعالَمِينَ حَتّىٰ فاقَ فَضْلُهُمْ فَضْلَ الْعالَمِينَ جَمِيعاً.
أسأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَأَنْ تَكْشِفَ عَنّي غَمّي وَهَمّي وكَرْبي ، وَتَكْفِيَني الْمُهِمَّ مِنْ اُمُوري ، وَتَقْضي عَنّي ديوني ، وَتُجِيرَني مِنَ الْفَقْرِ ، وَتُجِيرَني مِنَ الْفاقَةِ ، وَتُغْنِيَني عَنِ الْمَسْأَلَةِ إِلَى الْمَخْلُوقِينَ ، وَتَكْفِيَني هَمَّ مَنْ أَخافُ هَمَّهُ ، وَجَوْرَ مَنْ أَخافُ جَوْرَهُ ، وَعُسْرَ مَنْ أَخافُ عُسْرَهُ ، وَحُزُونَةَ مَنْ أَخافُ حُزُونَتَهُ ، وَشَرَّ مَنْ أَخافُ شَرَّهُ ، وَمَكْرَ مَنْ أَخافُ مَكْرَهُ ، وَبَغْيَ مَنْ أَخافُ بَغْيَهُ ، وَسُلْطانَ مَنْ أَخافُ سُلْطانَهُ ، وَكَيْدَ مَنْ أَخافُ كَيْدَهُ ، وَمَقْدُرَةَ مَنْ أَخافُ بَلاءَ مَقْدُرَتَهُ عَلَيَّ ، وَتَرُدَّ عَنّي كَيْدَ الْكَيَدَةِ ، وَمَكْرَ الْمَكَرَةِ.
اللّهُمَّ مَنْ أَرادَني فَأَرِدْهُ ، وَمَنْ كادَني فَكِدْهُ ، وَاصْرِفْ عَنّي كَيْدَهُ وَمَكْرَهُ وَبَأْسَهُ وَأَمانِيَّهُ ، وَامْنَعْهُ عَنّي كَيْفَ شِئْتَ وَأَنّىٰ شِئْتَ.
اللّهُمَّ اشْغَلْهُ عَنّي بِفَقْرٍ لَا تَجْبُرُهُ ، وَبِبَلاءٍ لَا تَسْتُرُهُ ، وَبِفاقَةٍ لَا تَسُدَّها ، وَبِسُقْمٍ لا تُعافِيهِ ، وَذُلٍّ لَا تُعِزُّهُ ، وَبِمَسْكَنَةٍ لَا تَجْبُرُها.
اللّهُمَّ اضْرِبْ بِالذُّلِّ نَصْبَ عَيْنَيْهِ ، وَأَدْخِلْ عَلَيهِ الْفَقْرَ في مَنْزِلِهِ ، وَالْعِلَّةَ وَالسُّقْمَ في بَدَنِهِ حَتّىٰ تَشْغَلَهُ عَنّي بِشُغْلِ شاغِلٍ لَا فَراغَ لَهُ ، وَأَنْسِهِ ذِكْري كَما أَنْسَيْتَهُ ذِكْرَكَ ، وَخُذْ عَنّي بِسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَلِسانِهِ وَيَدِهِ وَرِجْلِهِ وَقَلْبِهِ وَجَمِيعِ
جَوارِحِهِ ، وَأَدْخِلْ عَلَيْهِ في جَمِيعِ ذٰلِكَ السُّقْمَ وَلَا تَشْفِهِ حَتّىٰ تَجْعَلَ ذٰلِكَ لَهُ شُغْلاً شاغِلاً بِهِ عَنّي وَعَنْ ذِكْري ، وَاكْفِني يا كافِيَ ما لَا يَكْفي سِواكَ فَإِنَّكَ الْكافي لَا كافي سِواكَ ، وَمُفَرِّجٌ لَا مُفَرِّجَ سِواكَ ، وَمُغِيثٌ لَا مُغِيثَ سِواكَ ، وَجارٌ لَا جارَ سِواكَ ، خابَ مَنْ كانَ جارُهُ سِواكَ ، وَمُغِيثُهُ سِواكَ ، وَمَفْزَعُهُ إِلىٰ سِواكَ ، وَمَهْرَبُهُ إِلىٰ سِواكَ ، وَمَلْجَأُهُ إِلىٰ غَيْرِكَ ، وَمَنْجاهُ مِنْ مَخْلُوقٍ غَيْرِكَ ، فَأَنْتَ ثِقَتي وَرَجائي وَمَفْزَعي وَمَهْرَبي وَمَلْجأي وَمَنْجايَ ، فَبِكَ أَسْتَفْتِحُ ، وَبِكَ أَسْتَنْجِحُ ، وَبِمُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ وَأَتَوسَّلُ وَأَتَشَفَّعُ.
فَأَسْأَلُكَ يا اللهُ يا اللهُ يا اللهُ ، وَلَكَ الشُّكْرُ وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكىٰ وَأنْتَ الْمُسْتَعانُ ، فَأَسْأَلُكَ يا اللهُ يا اللهُ يا اللهُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ أَنْ تُصَلِّيَ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَن تَكْشِفَ عَنّي غَمّي وَهَمّي وَكَرْبي في مَقامي هٰذا كَما كَشَفْتَ عَنْ نَبِيِّكَ هَمَّهُ وَغَمَّهُ وَكَرْبَهُ ، وَكَفَيْتَهُ هَوْلَ عَدُوِّهِ ، فاكْشِفْ عَنّي كَما كَشَفْتَ عَنْهُ ، وَفَرِّجْ عَنّي كَما فَرَّجْتَ عَنْهُ ، وَاكْفِني كَما كَفَيْتَهُ ، واصْرِفْ عَنّي هَوْلَ ما أَخافُ هَوْلَهُ ، وَمَؤُنَةَ ما أَخافُ مَؤُنَتَهُ ، وَهَمَّ ما أَخافُ هَمَّهُ بِلَا مَؤُنَةٍ عَلىٰ نَفْسي مِنْ ذٰلِكَ ، وَاصْرِفْني بِقَضاءِ حَوائِجي ، وَكِفايَةِ ما أَهَمَّني هَمُّهُ مِنْ أَمْرِ آخِرَتي وَدُنْيايَ.
يا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَيا أَبا عَبْدِ اللهِ ، عَلَيْكُما مِنّي سَلَامُ اللهِ أَبَداً ما بَقِيتُ وَبَقِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ ، وَلَا جَعَلَهُ اللهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِيارَتِكُما ، وَلَا فَرَّقَ بَيْني وَبَيْنَكُما.
اللّهُمَّ أحْيِني حَياةَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَذُرِّيَّتِهِ ، وَأَمِتْني مَماتَهُمْ ، وَتَوَفَّني عَلىٰ مِلَّتِهِمْ ، وَاحْشُرْني في زُمْرَتِهِمْ ، وَلَا تُفَرِّقْ بَيْني وَبَيْنَهُمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَداً في
الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ.
يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ وَيا أَبا عَبْدِ اللهِ ، أَتَيْتُكُما زائِراً وَمُتَوَسِّلاً إِلَى اللهِ رَبّي وَرَبِّكُما ، وَمُتَوَجِّهاً إِلَيْهِ بِكُما ، وَمُسْتَشْفِعاً بِكُما إِلَى اللهِ تَعالىٰ في حاجَتي هٰذِهِ فاشْفَعا لي فَإِنَّ لَكُما عِنْدَ اللهِ الْمَقامَ الْمَحْمُودَ ، وَالْجاهَ الْوَجِيهَ ، وَالْمَنْزِلَ الرَّفِيعَ وَالْوَسِيلَةَ ، إِنّي أَنْقَلِبُ عَنْكُما مُنْتَظِراً لِتَنَجُّزِ الْحاجَةِ وَقَضائِها وَنَجاحِها مِنَ اللهِ بِشَفاعَتِكُما إِلَى اللهِ في ذٰلِكَ فَلَا أَخِيبُ يا رَبّ ، وَلَا يَكُونُ مُنْقَلَبي مُنْقَلَباً خائِباً خاسِراً ، بَلْ يَكُونُ مُنْقَلَبي مُنْقَلَباً راجِحاً مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجاباً بِقَضاءِ جَمِيعِ حَوائِجي وَتَشَفَّعاً لي إِلَى اللهِ ، أَنْقَلِبُ عَلىٰ ما شاءَ اللهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ، مُفَوِّضاً أَمْري إِلَى اللهِ ، مُلْجِأً ظَهْري إِلَى اللهِ ، مُتَوَكِّلاً عَلَى اللهِ ، وَأَقُولُ حَسْبِيَ اللهُ وَكَفىٰ ، سَمِعَ اللهُ لِمَنْ دَعا ، لَيْسَ لي وَراءَ اللهِ وَوَراءَكُمْ يا سادَتي مُنْتَهىٰ ، ما شاءَ اللهُ كانَ وَما لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ أَسْتَوْدِعُكُمَا اللهَ ، وَلَا جَعَلَهُ اللهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّي إِلَيْكُما.
انْصرَفْتُ يا سَيِّدي يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَوْلَايَ ، وَأَنْتَ يا أَبا عَبْدِ اللهِ يا سَيِّدَيَّ ، وَسَلَامي عَلَيْكُما مُتَّصِلٌ ما اتَّصَلَ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ ، واصِلٌ ذٰلِكَ إِلَيْكُما غَيْرُ مَحْجُوبٍ عَنْكُما سَلَامي إِنْ شاءَ اللهُ ، وَأَسْأَلُهُ بِحَقِّكُما أَنْ يَشاءَ ذٰلِكَ وَيَفْعَلَ فَإِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.
انْقَلَبْتُ يا سَيِّدَيَّ عَنْكُما تائِباً حامِداً لِلّهِ تَعالىٰ ، شاكِراً راجِياً لِلْإِجابَةِ ، غَيْرَ آيِسٍ وَلَا قانِطٍ آئِباً عائِداً راجِعاً إِلى زِيارَتِكُما ، غَيْرَ راغِبٍ عَنْكُما وَلَا عَنْ زِيارَتِكُما ، بَلْ راجِعٌ عائِدٌ إنْ شاءَ اللهُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.
يا سادَتي (١) رَغِبْتُ إِلَيْكُما وَإِلىٰ زِيارَتِكُما بَعْدَ أَنْ زَهِدَ فِيكُما وَفي زِيارَتِكُما أَهْلُ الدُّنْيا فَلَا خَيَّبَنِيَ اللهُ ما رَجَوْتُ وَما أَمَّلْتُ في زِيارَتِكُما ، إِنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبٌ.
قال سيف بن عميرة : فسألت صفوان فقلت له : إن علقمة بن محمّد الحضرمي لم يأتنا بهذا عن أبي جعفر عليه السلام إنّما أتانا بدعاء الزيارة.
فقال صفوان : وردت مع سيدي أبي عبد الله عليه السلام إلى هذا المكان ، ففعل بمثل الذي فعلناه في زيارتنا ، ودعا بهذا الدعاء عند الوداع بعد أن صلى صلينا ، وودع كما ودعنا.
ثم قال لي صفوان : قال لي أبو عبد الله عليه السلام :تعاهد هذه الزيارة ، وادع بهذا الدعاء ، وزر به ، فإنّي ضامن على الله تعالى لكلّ من زار بهذه الزيارة ودعا بهذا الدعاء من قرب أو بعد أن زيارته مقبولة ، وسعيه مشكور ، وسلامه واصل غير محجوب ، وحاجته مقضية من الله بالغاً ما بلغت ولا يخيّبه.
يا صفوان ، وجدت هذه الزيارة مضمونة بهذا الضمان عن أبي ، وأبي عن أبيه علي بن الحسين عليهم السلام ، مضموناً بهذا الضمان ، وعلي بن الحسين عن أبيه الحسين
__________________
(١) قوله: «يا سادَتي» إمّا بتشديد الياء من باب المثنّى ، أو بالتخفيف بكون الياء ياء المتكلّم ، وعلى التقديرين الأمر في الثالثة من باب المجاز بكونه جمعاً للسيّد ، كما هو مقتضى كلام صاحب المصباح ، أو جمعاً للسائد ، كما هو مقتضى كلام صاحب القاموس ، فالأمر نظير قوله سبحانه: (
فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا
)
[التحريم ٦٦ : ٤] وغيره ممّا استعمل فيه الجمع في الآيتين مجازاً بناءً على كون أقلّ الجمع ثلاثة كما هو المشهور المنصور ، وحرّرناه في الاُصول.
وأمّا قوله عليه السلام : «يا سادَتي» سابقاً ، فهو بالتخفيف ، والجمع فيه مستعمل على وجه الحقيقة ، منه عفي عنه.
مضموناً بهذا الضمان ، والحسين عن أخيه الحسن مضموناً بهذا الضمان ، والحسن عن أبيه أمير المؤمنين مضموناً بهذا الضمان ، وأمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله مضموناً بهذا الضمان ، ورسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرئيل مضموناً بهذا الضمان ، وجبرئيل عن الله عزّ وجلّ مضموناً بهذا الضمان.
وقد آلى الله على نفسه عزّ وجلّ أن من زار الحسين عليه السلام بهذه الزيارة من قرب أو بعد ودعا بهذا الدعاء قبلت منه زيارته وشفّعته في مسألته بالغاً ما بغلت ، وأعطيته سؤله ، ثم لا ينقلب عني خائباً ، وأقلبه مسروراً قرير العين بقضاء حاجته ، والفوز بالجنة والعتق من النار ، وشفّعته في كل من شفع خلا ناصب لنا أهل البيت ، آلى الله تعالى بذلك على نفسه وأشهدنا بما شهدت به ملائكة ملكوته على ذلك.
ثم قال جبرئيل : يا رسول الله إن الله أرسلني إليك سروراً وبشرى لك ، وسروراً وبشري لعليّ وفاطمة والحسن والحسين وإلى الأئمّة من ولدك إلى يوم القيامة ، فدام يا محمّد سرورك وسرور عليّ وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة وشيعتكم إلى يوم البعث.
ثم قال لي صفوان : قال لي أبو عبد الله عليه السلام :يا صفوان ، إذا حدث لك إلى الله حاجة فزر بهذه الزيارة من حيث كنت ، وادع بهذا الدعاء وسل ربك حاجتك تأتك من الله ، والله غير مخلف وعده ورسوله صلى الله عليه وآله بمنه والحمد الله »(١) .
فيما قاله محمّد بن المشهدي
وقال محمّد بن المشهدي صاحب المزار الكبير(٢) نقلاً في زيارة سيّد الشهداء يوم عاشوراء من قريب أو بعيد تقول :السَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أَبا عَبْدِ اللهِ.
__________________
(١) مصباح المتهجّد وسلاح المتعبّد : ٧٧٧.
(٢) المزار : ٤٨٠.
ثم ذكر الزيارة إلى قوله :وَآلِ نَبِيِّكَ عَلَيْهِمُ.
قال : ثم تقول :اللّهُمَّ الْعَنْ أَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ إلى آخره ، تقول ذلك مائة مرة ، ثمّ تقول :السَّلامُ عَلَيْكَ يا أَبا عَبْدِاللهِ إلى آخره ، يقول ذلك مائة مرة.
قال : ثمّ تقول :اللّهُمَّ خُصَّ أَنْتَ أَوَّلَ ظالِمٍ بِاللَّعْنِ مِنّي إلى آخره.
قال : ثم تسجد وتقول :اللّهمَّ لَكَ الْحَمْدُ إلى آخره ، وختم الكلام.
وأنت خبير بأن مقتضاه خلوّ الزيارة عن الصلاة.
وقال نقلاً أيضاً(١) عند ذكر زيارات أمير المؤمنين عليه السلام : روى محمّد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، قال : «خرجت مع صفوان بن مهران الجمّال وجماعة من أصحابنا إلى الغريّ بعد ما ورد أبو عبد الله عليه السلام ، فزرنا أمير المؤمنين عليه السلام ، فلمّا فرغنا من الزيارة صرف صفوان وجهه إلى ناحية أبي عبد الله عليه السلام وقال :نزور الحسين بن عليّ عليهما السلام من هذا المكان من عند رأس أمير المؤمنين عليه السلام.
وقال صفوان : وردت مع سيّدي أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمّد صلوات الله عليه ففعل مثل هذا ودعا بهذا الدعاء ، بعد أن صلّى وودّع.
ثمّ قال لي : يا صفوان ، تعاهد هذه الزيارة ، وادع بهذا الدعاء ، وزرهما بهذه الزيارة ، فإنّي ضامن على الله لكلّ من زارهما بهذه الزيارة ، ودعا بهذا الدعاء ، من قُربٍ أو بُعدٍ ، أنّ زيارته مقبولة ، وأنّ سعيه مشكور ، وسلامه واصل غير محجوب ، وحاجته مقضيّة من الله بالغاً ما بلغت ، وأنّ الله يخيبه.
يا صفوان ، وجدت هذه الزيارة مضمونة بهذا الضمان عن أبي ، وأبي عن أبيه عليّ بن الحسين ، وعليّ بن الحسين عن أبيه الحسين ، والحسين عن أخيه الحسن ، عن أمير المؤمنين مضموناً بهذا الضمان ، وأمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله ،
__________________
(١) أي محمّد بن المشهدي في مزاره : ٢١٤.
عن جبرئيل عليه السلام مضموناً بهذا الضمان. قد آلى الله على نفسه عزّ وجلّ أنّ من زار الحسين بن عليّ عليهما السلام بهذه الزيارة من قرب أو بعد في يوم عاشوراء ، ودعاء بهذا الدعاء قبلت زيارته ، وشفّعته في مسألته بالغاً ما بلغت ، وأعطيته سؤله ، ثمّ لا ينقلب عنّي خائباً ، وأقلبه مسروراً قريراً عينه بقضاء حوائجه ، والفوز بالجنة والعتق من النار ، وشفّعته في كلّ من شفع له ما خلا الناصب لنا أهل البيت. آلى الله تعالى بذلك على نفسه ، وأشهد ملائكته على ذلك.
وقال جبرئيل : يا محمّد ، إنّ الله أرسلني إليك مبشّراً لك ولعليّ وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة من ولدك إلى يوم القيامة ، فدام سرورك يا محمّد وسرور عليّ وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة من ولدك وشيعتكم إلى يوم البعث.
وقال صفوان :قال أبو عبد الله عليه السلام : يا صفوان ، إذا حدث لك إلى الله حاجة فزره بهذه الزيارة من حيث كنت ، وادع بهذا الدعاء ، وسل ربّك حاجتك تأتك من الله ، والله غير مخلف وعده ورسوله صلى الله عليه وآله بمنّه ، والحمد لله. وهذه الزيارة :السلام عليك يا رسول الله ...؟ إلى آخر الزيارة (١) .
وهي مذكورة في «البحار»(٢) و «تحفة الزائر» إلى آخر تلك الزيارة ، وهو قوله :فإِنّي عَبْدُ اللهِ وَوَلِيُّكَ وَزائِرُكَ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ.
ثم قال(٣) : وصل ستّ ركعات صلاة الزيارة وادع ما أحببت.
قال : ثم قل :السَّلَامُ عَلَيْكَ يا أَميرَ الْمُؤْمِنينَ ، عَلَيْكَ مِنّي سَلَامُ اللهِ أَبَداً ما بَقيتُ وَبَقِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ.
قال :ثم أومئ إلى الحسين عليه السلام وقل :السَّلَامُ عَلَيْكَ يا أَبا عَبْدِ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ
__________________
(١) أي زيارة أمير المؤمنين عليه السلام. منه عفي عنه.
(٢) بحار الأنوار: ٩٧: ٣٠٥.
(٣) أي محمّد بن المشهدي في مزاره: ٢٢١.
يَابْنَ رَسُولِ اللهِ.
[يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ وَيا أَبا عَبْدِ اللهِ] ، أَتَيْتُكُما زائِراً وَمُتَوَسِّلاً إِلى اللهِ رَبّي وَرَبَّكُما ، وَمُتَوَجِّهاً إِلَيْهِ بِكُما ، وَمُسْتَشْفِعاً بِكُما إِلَى اللهِ في حاجَتي هٰذِهِ فاشْفَعا لي فَإِنَّ لَكُما عِنْدَ اللهِ الْمَقامَ الْمَحْمُودَ ، وَالْجاهَ الْوَجِيهَ ، وَالْمَنْزِلَ الرَّفِيعَ وَالْوَسِيلَةَ في ذلِكَ ، إِنّي أَنْقَلِبُ عَنْكُما مُنْتَظِراً لِتَنَجٌّزِ الْحاجَةِ وَقَضائِها وَنَجاحِها مِنَ اللهِ بِشَفاعَتِكُما لي إِلَى اللهِ في ذٰلِكَ فَلَا أَخِيبُ ، وَلَا يَكُونُ مُنْقَلَبي عَنْكُما مُنْقَلَباً خائِباً خاسِراً ، بَلْ يَكُونُ مُنْقَلَبي مُنْقَلَباً راجِحاً مُفْلِحاً مُسْتَجاباً بِقَضاءِ جَمِيعِ الْحوائِج ، فَاشْفَعا لي إِلَى اللهِ ، انْقَلِبُ عَلىٰ ما شاءَ اللهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ، مُفَوِّضاً أَمْري إِلَى اللهِ ، مُلْجِأً ظَهْري إِلَى اللهِ ، مُتَوَكِّلاً عَلَى اللهِ ، وَأَقُولُ حَسْبِيَ اللهُ وَكَفىٰ ، سَمِعَ اللهُ لِمَنْ دَعا ، لَيْسَ لي وَراءَ اللهِ وَوَراءَكُمْ يا سادَتي مُنْتَهىٰ ، ما شاءَ رَبّي كانَ وَما لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ ، [وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ أَسْتَوْدِعُكُمَا اللهَ ، وَلَا جَعَلَهُ اللهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّي إِلَيْكُما].
يا سَيِّدي يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَوْلَايَ ، وَأَنْتَ يا أَبا عَبْدِ اللهِ يا سَيِّدَيَّ ، سَلَامي عَلَيْكُما مُتَّصِلٌ ما اتَّصَلَ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ ، واصِلٌ ذٰلِكَ إِلَيْكُما غَيْرُ مَحْجُوبٍ عَنْكُما سَلَامي إِنْ شاءً اللهُ ، وَأَسْأَلُهُ بِحَقِّكُما أَنْ يَشاءَ ذٰلِكَ وَيَفْعَلَ فَإِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.
انْقَلِبُ يا سَيِّدَيَّ عَنْكُما تائِباً حامِداً لِلّهِ شاكِراً راضِياً مُسْتَيْقِن لِلْإِجابَةِ ، غَيْرَ آيِسٍ وَلَا قانِطٍ آئِباً عائِداً راجِعاً إِلىٰ زِيارَتِكُما ، غَيْرَ راغِبٍ عَنْكُما ، بَلْ راجِعٌ عائِدٌ إنْ شاءَ اللهُ إِلَيْكُما.
يا ساداتي رَغِبْتُ إِلَيْكُما بَعْدَ أَنْ زَهِدَ فِيكُما وَفي زِيارَتِكُما أَهْلُ الدُّنْيا فَلَا خَيَّبَنِيَ اللهُ في ما رَجَوْتُ وَما أَمَّلْتُ في زِيارَتِكُما إِنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبٌ.
قال : ثم انتقل إلى القبلة وقل :يا اللهُ يا الله ُ يا الله ُ ، يا مُجِيبَ دَعوَةِ الْمُضْطَرِّينَ ، إلى قوله :وَاصْرِفْني بِقَضاءِ حَاجتي ، وَكِفايَةِ ما أَهَمَّني هَمُّهُ مِنْ أَمْرِ دُنْيايَ وَآخِرَتي ، يا أَرْحَمَ الرّاحمينَ.
قال : ثم تلتفت إلى أمير المؤمنين وتقول :السَّلَامُ عَلَيْكَ يا أَميرَ الْمؤْمِنينَ ، وَالسَّلَامُ عَلىٰ أَبي عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْن ما بَقِيتُ وَبَقِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ ، لَا جَعَلَهُ اللهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّي لِزيارَتِكُما ، وَلَا فَرَّقَ اللهُ بَيْني وبَيْنَكُما ، ثم تنصرف؟ انتهى(١) .
تحرير الكلام في المقام
وأنت خبير بأن هذه الرواية ساكتة عن كيفية الزيارة في فعل صفوان.
أقول : إن في رواية كامل الزيارة بيان للزيارة صدراً في قوله عليه السلام : «وأومئ إليه بالتسليم ، واجتهد على قاتله بالدعاء ، وصلَّ بعده ركعتين » ، وذيلاً في قوله عليه السلام : «إذا أنت صلّيت الركعتين بعد أن تومئ إليه بالسلام ، وقلت عند الإيماء إليه بعد الركعتين هذا القول ».
وفي رواية «المصباح» عن محمّد بن إسماعيل أيضاً بيان للزيارة صدراً في قوله عليه السلام : «وأومئ إليه بالسلام ، واجتهد في الدعاء على قاتليه ، وصل من بعد ركعتين » ، وذيلاً في قوله عليه السلام : «إذا أنت صلّيت الركعتين بعد أن تومئ إليه بالسلام فقل عند الإيماء إليه بعد التكبير هذا القول ».
__________________
(١) هذا نهاية ما ذكره محمّد بن المشهدي في مزاره.
وكل من الصدرين(١) ظاهر المعنى ولا إشكال فيه ، ومقتضى كل منهما تأخر الركعتين عن الزيارة ، وعلى هذا المنوال الحال في قضية صفوان المدلول عليها في رواية «المصباح» بقوله : «فدعا صفوان بالزيارة التي رواها علقمة بن محمّد الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام في يوم عاشوراء ثمّ صلّى ركعتين وودّع في دبرهما أمير المؤمنين وأومئ إلى الحسين عليه السلام منصرفاً بوجهه نحوه وودّع في دبرها».
بناءً على أن الظاهر كون الإيماء بعد الركعتين للوداع لا للزيارة ، بل لا إشكال فيه ، فمقتضاها تأخر الركعتين عن الزيارة أيضاً ، وليس فيما رواه في المزار الكبير(٢) مخالفة لذلك ، بل هو خال عن بيان كيفية الزيارة بالكلية ، كما سمعت.
لكن مقتضى كل من الذيلين(٣) تأخر الزيارة عن الصلاة.
إلا أن الذيل في رواية «المصباح» ظاهر أيضاً وخال عن الإشكال ، هذا بناء عن أنه لا إشكال في كون قوله عليه السلام : «فقل» جواباً للشرط ، لكن لو كان معطوفاً على قوله عليه السلام : «تومئ» كما جرى عليه بعض الأعلام ، كما يأتي ، فمقتضاه تأخر الركعتين عن الزيارة ، وأما ذيل كامل الزيارة ، فقوله :«وقلت» معطوف على قوله : «وصيلت» ، ولا مجال للعطف على قوله : «تومئ» ؛ إذ لا مجال لدخول أنْ المصدرية على الفعل الماضي ، مع أن قوله : «من بعد الركعتين» ينافي ذلك للزوم كون الركعتين بعد الركعتين.
إلّا أن يقال : إنه مبني على اتحاد الركعتين في الصدر والذيل ، وأما على تقدير التعدد فلا محذور في الباب من هذه الجهة ، إلّأ أنه يلزم مخالفة الذيل للصدر لاقتضاء الصدر كون المدار على اتحاد الزيارة والصلاة ، واقتضاء الذيل بتعدد الزيارة
__________________
(١) مراه بالصدرين : صدر ما ذكره عن كامل الزيارة ، وصدر ما ذكره عن المصباح.
(٢) يعني به محمّد بن المشهدي الذي تقدّم ذكر عبارته.
(٣) مراده بالذيلين: ذيل ما ذكره عن كامل الزيارة ، وذيل ما ذكره عن المصباح.
والصلاة ، بأن أومئ وصلى وأومئ وصلى أيضاً ، وقوله : «بعد الركعتين» ، هكذا مرسوم في النسخة التي عندي من كامل الزيارة.
وكذا في متن «البحار» ، والنسخة التي عندي من«البحار» قوبلت مع نسخة المؤلف العلّامة ، على ما كتب في آخر الكتاب ، لكن في الفوق وبعد ، نقلاً عن بعض النسخ ، لكن حكى بعض الأعلام عن بعض نسخ «البحار» أن المرسوم في المتن كان وبعد ، وكان مرسوماً بين السطور بدل الواو نقلاً عن بعض النسخ ، إلّا أنه يمكن أن يكون رسم الواو في هذه النسخة بين السطور من باب إفادة كون المرسوم في بعض النسخ : ومن بعد.
فيما ذكره العلّامة المجلسي قدس سره في «البحار»
من وجوه الاحتمال في ذيل رواية كامل الزيارة.
قال العلّامة المجلسي قدس سره في «البحار» ، قوله عليه السلام : «إذا أنت صليت الركعتين ».
أقول : في العبارة إشكال وإجمال ويحتمل وجوهاً :
الأوّل : أن يكون المراد فعل تلك الأعمال والأدعية قبل الصلاة وبعدها مكرراً.
الثاني : أن يكون المراد الإيماء بسلام آخر بأي لفظ أراد ثم الصلاة ثم قراءة هذه الأدعية المخصوصة.
الثالث : أن يكون المراد بالسلام قوله : «السلام عليك» إلى أن ينتهي إلى الأذكار المكررة ثم يصلي ويكرر كُلاً من الدعائين مائة بعد الصلاة ويأتي بما بعدهما.
الرابع : أن يكون الصلاة بعد تكرار الذكرين مائة ثم يقول بعد الصلاة : «اللهم خص أنت أول ظالم» إلى آخر الأدعية.
الخامس :
أن تكون الصلاة متوسطة بين هذين الذكرين لقوله عليه السلام :
«
واجتهد على
قاتله بالدعاء وصل بعده »(١) .
السادس : أن تكون الصلاة متصلة بالسجود(٢) ، ولعل هذا أظهر ، لمناسبة السجود بالصلاة ، ولأن ظاهر الخبر كون الصلاة بعد كل سلام ولعن.
واحتمال كون الصلاة بعد الأذكار من غير تكرير بعدها ، بعيد جداً.
ثم اعلم أن في «المصباح» ومزار السيّد(٣) مكان قوله عليه السلام : «من بعد الركعتين» قوله : «من بعد التكبير» ، فلعلّ المراد بالتكبير الصلاة مجازاً.
وعلى التقادير العبارة في غاية التشويش ، ولعلّ الأحوط فعل الصلاة في المواضع المحتملة(٤) [انتهى كلام «البحار»].
تمهيد مقدمة لشرح كلام العلّامة المجلسي قدس سره في «البحار»
وشرح كلامه وكلامه في شرح الحال من باب شرح الإجمال بالإجمال ، بل بمزيد الإجمال ، بل كمال الإجمال يبتني على تمهيد مقدمة : هي أنه لو قيل : «أعط زيداً وعمرواً خمسة دراهم».
فهل العطف ظاهر في إعطاء كل من المتعاطفين أعني زيداً وعمرواً خمسة دراهم.
أو ظاهر العطف يقتضي التجزئة بإعطاء زيد درهماً وإعطاء عمرو أربعة دراهم.
أو إعطاء زيد درهمين وإعطاء عمرو ثلاثة دراهم.
__________________
(١) قوله : «الخامس» أنت خبير بأنّ المناسب بحسب الترتيب أن يقدّم هذا الوجه على الوجه الرابع. منه رحمه الله.
(٢) قوله: «متّصلة بالسجود» والغرص الاتّصال من جانب السبق. منه رحمه الله
(٣) مراده من مزار السيّد: مصباح الزائر للسيّد ابن طاووس.
(٤) بحار الأنوار: ٩٨: ٣٠١ ، الباب ٢٤.
وهكذا إلى أن ينتهي بإعطاء زيد أربعة دراهم وإعطاء عمرو درهماً.
أو العطف مردد بين تكرير إعطاء الكل والتجزئة بوجوهها؟
الأظهر الأوّل نظراً إلى أن الغالب في استعمالات حروف العطف في باب عطف المفرد على المفرد كون العطف بعد تمامية الكلام بالمعطوف عليه ، نعم قد يعطف بالواو ما لا يستغني عنه ، نحو «اختصم زيد وعمرو» ، و «جلس زيد وعمرو» ، بل يختص بالواو من بين حروف العطف بذلك ، ومن هذا ما عن الأصعمي من أنه قال في قول امرئ القيس : «بسقط اللوى بين الدخول فحومل» أن الصواب أن يقال : بين الدخول وحومل ، لكن قد تعطف بأم المتصلة أيضاً مما لا يستغنى عنه نحو «سواء علي أقمت أم قعدت» ، فعطف ما لا يستغنى عنه بالواو بعيد نادر في استعمالات الواو ، وبعد ندرة هذا الاستعمال بالنسبة إلى سائر حروف العطف فلا مجال للإجمال في المثال المذكور فضلاً عن التجزئة المترددة بين الأقسام.
هذا كله لو كان التجزئة غير محتاجة إلى التكسير ، وأما لو احتيج إلى التكسير نحو أعط زيداً وعمرواً درهماً ، فخلاف الظاهر في التجزئة أزيد.
هذا كتبته في سوابق الأحوال.
وتحرير الحال أن يقال : إن عطف المفرد على المفرد هل يقتضي إناطة الحكم باجتماع المفردين المتعاطفين ، أو يقتضي استقلال كل من المفردين في تعلق الحكم إليه ، مثلاً لو قيل : «أعط زيداً وعمرواً درهماً» ، هل يقتضي العطف إعطاء الدرهم إلى زيد وعمرو معاً ، فلكل منهما نصف درهم ، أو يقتضي إعطاء الدرهم إلى كلٍ من زيد وعمرو بالاستقلال.
الظاهر الاتفاق على الاستقلال لو قيل بالإضمار ، أعني إضمار العامل في المعطوف عليه للمعطوف بأن صار الأمر من باب عطف الجملة على الجملة ، كأن أضمر لفظ أعط عاملاً لعمرو في المثال المذكور ، وهو أعني الإنفاق المشار إليه
مقتضى التعليل الآتي من الشيخ(١) ، فالنزاع إنما يتأتى لو قيل بكون العامل في المعطوف عليه أو قيل يكون العامل في المعطوف هو الواو.
ومقتضى بعض كلمات ابن هشام في «المغني»(٢) في فاتحة واو المفرد أعني كون الأمر في الباب ، أعني عطف المفرد على الخلو عن الإضمار.
لكن الشهيد في «التمهيد» نقل قاعدة وهي إذا قلت : «قام زيد وعمرو» ، فالصحيح أن العامل في الثاني هو العامل في الأوّل بواسطة الواو ، وثاني الأقوال أن العامل فعل آخر مقدر بعد الواو ، والثالث أن الواو نفسها ، إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة ما إذا حلف أن لا يأكل هذا الرغيف وهذا الرغيف ، وعلى الأوّل لا يحنث إلّا بأكلهما جميعاً ، كما لو عبر بالرغيفين ، فعلى القول بأنه مقدر يكون كل منهما محلوفاَ عليه بانفراده فيجب بأكل كل منهما(٣) .
وبالجملة فمقتضى ما صنعه المحقّق في «الشرائع»(٤) ، حيث جرى على أنه لو قال : «لا أكلت هذا الخبز وهذا السمك» لا يحنث إلّا بأكلهما ، تعليلاً بأن الواو
__________________
(١) وقد روي في التهذيب في زيادات الحجّ ، وفي الاستبصار في كتاب الحجّ ـ باب إتمام الصلاة في الحرمين ، في ذيل ما رواه بالإسناد عن عليّ بن مهزيار ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه قال : «فإذا انصرف من عرفات إلى منى، وزرت البيت فرجعت إلى منى ، فأتمّ الصلاة تلك الثلاثة أيّام ، وقال بإصبعه ثلاثاً » ، والأمر فيه من باب عطف الجملة على الجملة ، وصريح النصّ كون الأمر من باب الاستقلال. منه رحمه الله.
(٢) مغني اللبيب: ١: ٤٦٣.
(٣) تمهيد القواعد: ٥٠٨ ، القاعدة ١٨٦.
(٤) شرائع الإسلام: ٣: ٧١٦ ، حيث قال في المسألة الحادية عشر: «لو قال : لا أكلت هذين الطعامين لم يحنث بأحدهما ، وكذا لو قال: لا أكلت هذا الخبز وهذا السمك لم يحنث إلّا بأكلهما؛ لأنّ الواو العاطفة للجمع ، فهي كألف التثنية. وقال الشيخ: لو قال: لا كلّمت زيداً وعمراً ، فكلّم أحدهما ، حنث؛ لأنّ الواو ينوب مناب الفعل ، والأوّل أصحّ».
للجمع وهي حينئذٍ كألف التثنية ، القول بالأوّل.
وهو مقتضى صريح الشهيد في «الدروس»(١) في كتاب النذر ، قال : قاعدة الجمع بين شيئين أو أشياء بواو العطف يصير كل واحد منهما مشروطاً بالآخر قضية الواو ، فلو قال : «لا أكلت الخبز واللحم والفاكهة» أو «لآكلنّها» ، فلا حنث إلّا بالثلاثة ولا بر إلّا بها.
ويقتضي القول بذلك ما أورد به صاحب «المدارك»(٢) على الاستدلال على كون الوضوء واجباً غيرياً ، بقوله عليه السلام : «إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة» ، حيث إن المشروط ينعدم عند عدم الشرط ، بأن المشروط وجوب الطهور والصلاة معاً ، وانتفاء هذا المجموع يتحقق بانتفاء أحد جزئيه ، فلا يتعين انتفائهما.
وغرضه أن المشروط وجوب مجموع الطهور والصلاة ، فمقتضى انتفاء المشروط بانتفاء الشرط هو انتفاء المجموع قبل الوقت لا انتفاء كل من الأمرين ، فغاية الأمر بثبوت عدم وجوب الطهور والصلاة معاً قبل الوقت ، ولا يثبت انتفائهما حتى يثبت عدم وجوب الوضوء فالأمر على ذلك من باب الاستغراق المجموعي ، ويمكن أن يكون من باب الاستغراق الأفرادي.
كما هو صريح «الذخيرة»(٣) .
لكنه خلاف الظاهر.
نعم لو كان الأمر من باب الاستغراق الأفرادي يصلح المقصود بناء على كون النفي في المفهوم راجعاً إلى العموم ويكون الأمر من باب سلب العموم.
__________________
(١) الدروس: ٢: ١٧١.
(٢) مدارك الأحكام: ١: ١٠ ، حيث قال: «وعلى الثاني: إنّ المشروط وجوب الطهور والصلاة معاً ، وانتفاء هذا المجموع يتحقّق بانتفاء أحد جزأيه ، فلا يتعيّن انتفاؤهما معاً».
(٣) ذخيرة المعاد: ١: ٢.
لكن الأظهر أن النفي في المفهوم لا يرجع إلى المقيد فالنفي الوارد على العموم لعموم السلب بالسنبة إلى الأفراد لو كان العموم من باب الاستغراق الأفرادي ، وبالنسبة إلى الأجزاء لو كان العموم من باب الاستغراق المجموعي.
ويقتضي القول بذلك أيضاً ما جرى عليه المحقّق القمّي(١) وبعض من تأخر عنه في باب الترجيح ، من أن المدار في قوله عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة : «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما في الحديث وأورعهما » على الزيادة في العدالة والفقاهة والصادقية والورع ، فالمرجح أمر واحد ، لا الزيادة في كل من الأمور المذكورة ، فيكون المرجح أمور أربعة ، كما رجحناه في محله.
ومقتضى ما عن الشيخ(٢) من أنه لو قال : «لا كلّمت زيداً وعمرواً» ، فكلّم أحدهما حنث ، تعليلاً بأن الواو تنوب مناب الفعل ، هو القول بالثاني.
وكيف كان فالحق في المقام أن الإضمار في المضمار خلاف الظاهر ولا داعي إلى ارتكابه.
لكن الظاهر في مثل «أعط زيداً وعمرواً» هو استقلال كل من زيد وعمرو في وجوب الإعطاء إليه ، مع فرض خلو الكلام عن الإضمار ، نعم قد يكون الأمر مبنياً
__________________
(١) المراد به صاحب القوانين في قوانين الاُصول: ٤٧٤.
(٢) في المبسوط: ٦: ٢٣١ ، حيث قال: «... فحلف لا أكلت هذين الرغيفين ، ولا لبست هذين الثوبين لم يحنث حتّى يأكلهما ، فإن أكل أحدهما لم يحنث. وقال بعضهم: يحنث إذا أكل أحدهما ؛ لأنّ أصله أن القرب من الحنث حنث ، والأوّل أصحّ عندنا ، فإن حلف لا كلّمت زيداً وعمرواً ، فكلّم أحدهما ، حنث.
والفرق بينهما أنّهما يمينان؛ لأنّه حلف لا كلّم زيداً ولا كلّم عمرواً، وإنّما دخلت الواو نائبة مناب تكرير الفعل ، كأنّه أراد أن يقول: والله لا كلّمت زيداً ولا كلّمت عمرواً ، فقال: وعمرواً ، فلهذا حنث ، وليس كذلك في الأوّل لأنّها يمين واحدة».
على الإناطة ، نحو الأسكنجبين هو الخل والسكر ، والبيت هو السقف والجدران ، لكن هذا من جهة قيام القرينة الخارجية.
ثم إنه لو قيل : «لا آكل اللحم ولا الخبز» ، فهل يتأتى الحنث بأكل اللحم أو الخبز على القول بعدم الحنث لو قيل : «لا آكل اللحم والخبز» ، بناء على كون الأمر من باب الإضمار ، أو لا؟ فالأمر في المثالين سواء ، ربما يظهر من بعض الكلمات القول بالأول ، لكن مقتضى بعض كلمات ابن هشام كون الأمر من باب عطف المفرد على المفرد وخلو الحال عن الإضمار ، وعلى هذا يتأتى الحنث بأكل اللحم والخبز على الأظهر دون ما جرى عليه الشهيد في التمهيد.
شرح كلام العلّامة المشار إليه في «البحار»
إذا عرفت ما سمعت فنقول : إن القول أن المقصود به الزيارة المذكورة مركب من خمس قطعات : (السلام الطويل) ، و (اللعن المكرّر مائة مرة) ، و (السلام المكرر مائة مرة) ، و (الدعاء بالتخصيص) ، و (السجدة).
والسلام(١) ، في قوله (بالسلام) إما أن يكون متحداً مع القول المذكور المركب من القطعات المذكورة ، أو يكون مختلفاً معه ، والوجوه المحتملة المذكورة في «البحار» دائرة بين اتحاد السلام والقول وتكرار القول في كل من المتعاطفين ، أي عند الإيماء وبعد الركعتين كما في الوجه الأوّل ، فالمدار فيه على الإيتان بالزيارة والصلاة بعدها وتكرار الزيارة بعد الصلاة.
وبعبارة أخرى : المدار فيه على الإتيان بالصلاة بين الزيارتين الكاملتين وتغاير السلام والقول والإتيان بالزيارة بتمامها بعد الركعتين ، بناء على كون العبارة (بعد الركعتين) أو (وبعد الركعتين) لو صح كون الواو حالية ، إلّا أن الواو الحالية إنما
__________________
(١) أي وكلمة السلام ، في قول صاحب بحار الأنوار المتقدّم.
تدخل على الجملة الإسمية أو الفعلية ، كما هو المرجع في الوجه الثاني ، فالمدار فيه على الإتيان بالسلام بأي نحو كان والصلاة بعدها والإتيان بالزيارة بتمامها بعد الصلاة والتجزئة بجعل ما يقال عند الإيماء هو القطعة الأولى(١) وما يقال بعد الصلاة هو القطعات الأربعة(٢) الباقية(٣) .
أو ما يقال عند الإيماء هو القطعتان الأوليان(٤) وما يقال بعد الصلاة هو القطعات الثلاث(٥) الباقية(٦) .
أو ما يقال عند الإيماء هو القطعات الثلاث(٧) الأولى وما يقال بعد الصلاة هو القطعتان(٨) الباقيتان(٩) .
أو ما يقال عند الإيماء هو القطعات الأربعة(١٠) الأولى وما يقال بعد الصلاة هو القطعة الأخيرة ، أي السجدة المشتملة على الدعاء(١١) .
__________________
(١) مراده بذلك: السلام الطويل.
(٢) مراده بذلك: اللعن المكرّر مائة مرّة ، والسلام المكرّر مائة مرّة ، واللعن بالتخصيص ، ودعاء السجود.
(٣) هذا هو الوجه الأوّل.
(٤) مراده بذلك: السلام الطويل ، واللعن المكرّر مائة مرّة.
(٥) مراده بذلك: السلام المكرّر مائة مرّة ، واللعن بالتخصيص ، ودعاء السجود.
(٦) هذا هو الوجه الثاني.
(٧) مراده بذلك: السلام الطويل ، واللعن المكرّر مائة مرّة ، والسلام المكرّر مائة مرّة.
(٨) مراده بذلك: اللعن بالتخصيص ، ودعاء السجود.
(٩) هذا هو الوجه الثالث.
(١٠) مراده بذلك: السلام الطويل ، واللعن المكرّر مائة مرّة ، والسلام المكرّر مائة مرّة ، واللعن بالتخصيص.
(١١) هذا هو الوجه الرابع.
وهذه الوجوه الأربعة هي المدار في الوجوه الأربعة الأخيرة المذكورة في «البحار»(١) .
لكن الظاهر أن السجدة خارجة عن القول وإن كانت مشتملة على الدعاء ، بل لعل الظاهر أن الدعاء بالتخصيص(٢) خارج أيضاً عن الزيارة ، فلا يتجه الوجه الرابع من الوجوه التي ذكرناها وهو الوجه الأخير من الوجوه المذكورة في «البحار»(٣) ، إذ لا يبقى لما بعد الصلاة شيءٌ من القول ، وهو خلاف قضية العطف ، بل لعله لا يتجه الوجه الثالث من الوجوه التي ذكرناها وهو الوجه الرابع من الوجوه المذكورة في «البحار».
وأما احتمال كون ما يقال عند الإيماء هو تمام القطعات الخمس(٤) فلا مجال له ، إذ لا يبقى لما بعد الصلاة شيءٌ ، وهو خلاف قضية العطف ، وهذا هو الوجه السابع الذي جعله(٥) بعيداً جداً ، كيف وقد سمعت عدم اتجاه الوجه السادس ، بل الوجه الرابع قضيته عدم بقاء شيء لما بعد الصلاة وهو خلاف قضية العطف بناء على خروج السجدة ، بل خروج الدعاء بالتخصيص(٦) عن القول.
__________________
(١) والتي تقدّم ذكره في نقل عبارة صاحب البحار ، وهي الوجه الثالث والرابع والخامس والسادس.
(٢) أي قوله عليه السلام: «اللّهُمَّ خُصَّ أَنْتَ أَوَّلَ ظالِمٍ ».
(٣) وهو الوجه السادس.
(٤) وهي: السلام الطويل ، واللعن المكرّر مائة مرّة ، والسلام المكرّر مائة مرّة ، واللعن بالتخصيص ، ودعاء السجود.
(٥) يعني صاحب بحار الأنوار.
(٦) أي قوله: «اللّهُمَّ خُصَّ أَنْتَ أَوَّلَ ظالِمٍ ».
الإيراد على كلام العلّامة المشار إليه في «البحار» بوجوه
ويتطرق الإيراد ، مضافاً إلى ما يظهر مما ذكر من عدم وجاهة الوجه السادس ، بوجوه :
فأوّلاً : بأن قوله (وقلت) على تقدير ثبوت الواو معطوف على قوله (وصيلت) ، ولا يتأتى كونه عطفاً على قوله (تومئ) ، لما سمعت من عدم دخول أن المصدرية على الفعل الماضي ، والظاهر أن المقصود بالإيماء هو الإيماء المستفاد من قوله (تومئ) ، فالظاهر اتحاد السلام والقول ، إذ لو اتحد ظرف ما يقال عند الإيماء أعني القول المذكور والسلام ، فالظاهر اتحاد المظروف ، ولا مجال لكون الواو حالية لما مرّ من دخول الواو الحالية على الجملة الإسمية أو الفعلية ، فالوجه الثاني غير متجه.
وثانياً : بأن التجزئة بأقسامها خلاف الظاهر فاحتمالها ضعيف الحال ، بل الاحتمال من ركيك الخيال ، لظهور القول في تمام القول بلا مقال وغلبة العطف بالواو فضلاً عن غيرها فيما يتم الكلام في المعطوف عليه ، فالظاهر من صور العطف بالواو هو الإتيان بالزيارة كاملة قبل الصلاة وبعدها ، لكن لعل الظاهر سقوط الواو أصح.
وثالثاً : بأن الظاهر ، بل بلا كلام أن المدار في وجوه التجزئة على اتحاد السلام والقول ، ولا خفاء في اطراد تلك الوجوه مع اختلاف السلام والقول ، فكان المناسب ، بل اللازم عليه أن يزيد أربعة احتمالات أخرى في التجزئة مع اختلاف السلام والقول استيفاء للاحتمالات المتطرقة في المقام لكونه في مقام الاستيفاء.
تلخيص المقال في باب ذيل رواية كامل الزيارة
وقد تحصل فيما مرّ أنه على تقدير انتفاء الواو يكون الظاهر اتحاد الإيماء والسلام ، فيكون المدار على الإيماء بالسلام بأي نحو كان والصلاة والزيارة ،
وعلى تقدير ثبوت الواو فالظاهر من القول تمام القول ، فالمدار على الإتيان بالزيارة قبل الصلاة وبعدها ، والأوّل هو الوجه الثاني من الوجوه المذكورة في «البحار» والثاني هو الوجه الأوّل.
قوله(١) : «ولعل الأحوط فعل الصلاة في المواضع المحتملة» ، يأتي شرح هذا الكلام في أول التنبيهات إن شاء الله.
وقد علمت فيما تقدم أن ذيل رواية كامل الزيارة وذيل رواية «المصباح» على الأظهر كما يظهر مما مرّ متوافقان على تقدم الصلاة بخلاف صدريهما وفعل صفوان المروي عن الصادق عليه السلام فإن مقتضاها تقدم الزيارة.
وعمدة الكلام في المقام إنما هو شرح حال هذا المرام أعني تقدم الصلاة أو الزيارة ، وهذا الحديث قد أعيى الأنظار وأعقم القرائح ، ولعل الأرجح(٢) القول بتقدم الزيارة لزيادة روايته(٣) على رواية تقدم الصلاة بواحدة ، بناء على كفاية
__________________
(١) أي قول صاحب البحار.
(٢) قوله: «ولعلّ الأرجح تقدّم الزيارة» قد حكى العلّامة السبزواري في مفاتيح النجاة أنّ بعض العلماء زعم تقدّم صلاة الزيارة على الزيارة هاهنا ، يعني المكان البعيد والصحيح والمشهور تأخّرها.
(٣) قوله: «لزيادة روايته» ربّما يؤيّد القول بتقدّم الصلاة تقدّم الصلاة فيما ورد في زيارة سيّد الشهداء عليه السلام مطلقاً من دون اختصاص بيوم عاشوراء بالبعيد ، أو يكون التأييد في صورة البعيد بناءً على عموم زيارة عاشوراء للقريب والبعيد ، حيث روي في الكافي والتهذيب: بالإسناد عن ابن أبي عمير ، قال: «قال أبو عبدالله عليه السلام: إذا بعدت بأحدكم الشقّة، ونأت الدار، فليصعد أعلى منزله، وليصلِّ الركعتين، وليوم بالسلام إلى قبورنا، فإنّ ذلك يصل إلينا».
ورواه في الفقيه مرسلاً عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، وتأتي الرواية المذكورة في المتن. منه رحمه الله.
الواحدة في الترجيح ، ولا يبعد القول به في مثل المقام ، وأن لا يتأتى الترجيح بها فيما تعارض أربعون رواية من الطرفين مثلاً وزاد إحداهما بواحدة ، نعم المنافاة بين الذيلين في باب اعتبار التكبير ورواية «المصباح» دون كامل الزيارة ، كما أنه تأتي المنافاة بينهما لو كان قوله عليه السلام : «فقل » في رواية «المصباح» معطوفاً على قوله عليه السلام : «تومئ » لاقتضائه تأخر الصلاة عن الزيارة ، بخلاف قوله : «وقلت» في رواية كامل الزيارة لاقتضائه تأخر الزيارة ، وأما ما اقتضاه رواية محمّد بن المشهدي من خلو الزيارة عن الصلاة فهو شاذ.
فيما جرى عليه بعض الأعلام(١) مع الكلام فيه
ولا يذهب عليك أن ما ذكرنا من توافق الذيلين(٢) على تقدم الصلاة إنما يبتنى على كون قوله عليه السلام : «فقل » في رواية «المصباح» جواباً للشرط كما هو الظاهر ، لكن جرى بعض الأعلام على طرح الاتحاد بينه وبين الصدر بجعله معطوفاً على : «أن تومئ» وجعل جواب الشرط قوله عليه السلام : «فإنّك إذا قلت » ، انتهى.
لكنك خبير بما فيه من مخالفة الظاهر غاية المخالفة وركاكة المعنى كمال الركاكة ، بعد صحة عطف الإنشاء على الإخبار.
لكن قد يقال : إن من تتبع الأحاديث رأى كثيراً منها لم يلاحظ فيه القواعد المقررة في علم العربية ، إما لعدم معرفة الراوي ذلك على وجهه أو لكون المراد ما يؤدي المعنى من غير تدقيق في ذلك ، وهاهنا لما كان مقام الآمر بهذا غير الرواي بقوله عليه السلام : «فقل » والظاهر أن هذا المقال مبني على النقل بالمعنى ، وإن أمكن أطراد الوجه الثاني من الوجهين المذكورين في ذلك المقال في النقل باللفظ.
__________________
(١) لم نعثر عليه.
(٢) يعني: ذيل رواية المصباح ، وذيل رواية كامل الزيارة.
لكن نقول : إن مجرّد كون الآمر في المقام من باب أحد الوجهين لا يوجب الظن بالجمع ، بل لو انفتح ذلك الباب ينسد باب التعارض لإمكان حمل أحد المتعارضين أو كليهما على ما لا يوافق القواعد المقررة في علم العربية رفعاً للتعارض وقصداً للجمع ، بل ينسد أبواب الاستدلال بالأخبار الخالية عن التعارض لاحتمال كون المراد ما لا يوافق القواعد المشار إليها ، فتدبر.
فالمنافاة بين الصدر والذيل لم يثبت ارتفاعه ، بل ما لم يلاحظ فيه القواعد المشار إليها أقل مما لوحظ فيه تلك القواعد بمراتب كثيرة فالمشكوك فيه يلحق بالغالب ، فعلى هذا يثبت المنافاة ويتأتى الظن بها.
والبعض المذكور من الأعلام جرى أيضاً على كون قوله عليه السلام : «وقلت » في رواية كامل الزيارة معطوفاً على قوله عليه السلام : «يومئ » ، وهذا لا يوجب رفع التعارض بين الصدر والذيل ، لكنه جرى على طرح الاتحاد أيضاً بأن الصدر والذيل في هذه الرواية لاقتضاء وحدة الحديث وحدة المراد منه ، بجعل قوله : «وقلت » معطوفاً على قوله : «تومئ ».
ودعوى : أن الركعتين إما أن يكون المراد منه التكبير إطلاقاً لاسم الكل على الجزء والقرينة ما في «المصباح» أو وقع سهواً من قلم الناسخ ، والأصل بعد التكبير سواء كان مع ذكر الواو ، أي مع «من» والمعنى على الثاني «إذا أنت صليت الركعتين بعد أن تومئ إليه بالسلام» بإتيان الإيماء في ضمن هذا القول من بعد التكبير ، وعلى الأوّل : «إذا أنت صلّيت الركعتين بعد هذا القول وبعد التكبير يكون لك ذلك الثواب الجزيل» ، فأورد السؤال بأن وحدة المراد وإن كانت مسلمة لكنها كما تحقق بإرجاع ما في كامل الزيارة إلى ما في «المصباح» كذلك تتحقق بالعكس ، بأن يكون المراد من التكبير على ما في «المصباح» الركعتين تسمية للكل باسم الجزء.
فأجاب : بأن حمل التكبير على ما في «المصباح» على الركعتين غير صحيح ،
لوجوه :
منها : أن صدر الحديث نص في أن الركعتين بعد الإيماء بالسلام وبعد المبالغة في اللعن على قاتله ، وأن ظاهر من صدره أن مطلق الإيماء إليه عليه السلام بالسلام بأي لفظ كان ، وكذا الحال في المبالغة في اللعن على قاتله صلوات الله عليه يتأتى به الامتثال وأنه كاف في ترتب الأجر والثواب ، وأن الظاهر من سياقه أن علقمة لما سمع ذلك منه عليه السلام استدعى منه قولاً مخصوصاً يأتي به في مقام الإيماء ذلك واللعن على قاتله الذين دل صدره على كونهما مقدمين على الركعتين لوضوح أن ما بيَّنه عليه السلام كان أكمل وأفضل وذلك يقتضي أن يكون ما علّمه عليه السلام إياه قبل الركعتين لا بعدهما ، وحمل التكبير في كلامه على الركعتين مناف لذلك كما لا يخفى ، فعلى هذا يكون ما علّمه عليه السلام من قوله : «السلام عليك يا أبا عبد الله» ، وكذا التسليم مائة مرة مقام مطلق الإيماء المذكور في صدره لكنه فرد كامل ، ويكون اللعن مائة مرة ، وكذا ما اشتمل عليه الصدر المذكور بقول : «السلام عليك يا أبا عبد الله» من اللعن على قاتله ومؤسسه ، وكذا قوله : «اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني ...» إلى آخره مقام مطلق اللعن المدلول عليه بذلك ، وهو أيضاً فرد كامل منه.
ومنها : أن المدلول عليه بصدر الحديث أن المعتبر في تلك الزيارة هو الإيماء إليه صلوات الله عليه بالسلام والمبالغة في اللعن على قاتله عليه السلام ، ثم الركعتان ، فلو حملنا التكبير في كلامه عليه السلام على الركعتين يكون المدلول عليه بذلك أن القول الذي علّمه إنما يكون بعدهما ، وأما قبلهما فلا يكون إلّا مطلق الإيماء بالسلام ، وأما اللعن على قاتله عليه السلام فلا مطلقاً ، فلاحظ الحديث مع دقة النظر حتى يتضح لك الحال وينكشف لك سر المقال.
ومنها : أن مقتضى هذا الحمل أن يكون المعتبر في تلك الزيارة الإيماء إليه بالسلام قبل الركعتين وبعدهما ، مع أن المدلول عليه بصدره هو أن المعتبر في ذلك
هو الإيماء إليه بالسلام قبلهما.
ومنها : أنه لو حمل التكبير على ما في «المصباح» على الركعتين يكون مدلول الحديث حينئذٍ أن يكون القول الذي عملّه عليه السلام بأسره بعدهما ، واللازم باطل ، أما الملازمة فظاهر إذ القول في قوله : «هذا القول» إشارة إلى ما علّمه عليه السلام من قوله عليه السلام : «السلام عليك يا أبا عبد الله ...» إلى آخره واللعن مائة مرة والتسليم كذلك.
فتقدير الكلام حينئذٍ هكذا : «إذا أنت صليت الركعتين بعد أن تومئ إليه بالسلام فقل عند الإيماء إليه عليه السلام من بعد الركعتين هذا القول» ، وأما بطلان اللازم فلقضية سيف بن عميرة مع صفوان في رواية الشيخ المتقدّمة ، حيث إن سيف بن عميرة حكى عن صفوان أنه صلى ركعتين بعد الزيارة ، وظاهر الحكاية أن فعل صفوان كان مطابقاً لما فهمه من كلام أبي جعفر عليه السلام والذي رواه عن علقمة في رواية كامل الزيارة والشيخ ، إلّا أنه كان الخلاف في الدعاء الذي دعا به صفوان بعد الصلاة ، فمقتضى ما فهمه سيف بن عميرة من كلام أبي جعفر عليه السلام تأخر الركعتين عن الزيارة ، وهو ينافي حمل التكبير على الركعتين لاقتضائه تأخر الزيارة عن الركعتين.
هذا كله في بيان المرجّحات لحمل التكبير في عبارة «المصباح» على ظاهره وعدم صحة حمله على الركعتين ، فلا بد من حمل الركعتين في عبارة الكامل على التكبير لما عملت من وحدة الحديث المستلزمة لوحدة المراد ، مضافاً إلى ما في حمل الركعتين على ظاهرهما في عبارة الكامل من الفساد فضلاً عما عرفته من الأوجه السالفة وذلك لأنّ «قلت» في قوله : «وقلت عند الإيماء إليه» عطف على «تومئ» في قوله : «بعد أن تومئ إليه بالسلام» ، وحينئذ مع ذكر الواو يكون مدلول الكلام الإيتان بذلك القول قبل الركعتين وبعدهما ، إذ التقدير حينئذ يكون هكذا : «إذا أنت صليت الركعتين بعد أن تومئ إليه بالسلام وقلت عند الإيماء إليه هذا القول» ، وكذا قلته بعد الركعتين يكون لك كذا ، وهو مما لا يلتزم به لكونه مخالفاً
لصدر الحديث وذيله ، أي حكاية سيف بن عميرة مع صفوان ، كما لا يخفى ، وهكذا الحال فيما إذا كان «قلت» عطفاً على فعل الشرط ، أي صليت ، هذا على تقدير ذكر الواو ، وأما على تقدير ذكر كلمة «من» فكذلك أيضاً.
قوله : «منها أن صدر الحديث نص» ، انتهى.
الظاهر أن كلاً من قوله : «وأن الظاهر من صدره» وقوله : «وأن الظاهر من سياقه» معطوف على قوله المذكور أعني قوله : «إن صدر الحديث» ، أو قوله : «وإن الظاهر من صدره» معطوف على قوله : «إن صدر الحديث» وقوله : «وإن الظاهر سياقه» معطوف على قوله : «إن الظاهر من صدر الحديث» ، والوجهان مبنيان على أن كلاً من المعطوف في المعطوف المتعدد معطوف على المعطوف عليه الأوّل ، أو المعطوف الأوّل معطوف على ما عطف عليه ، والمعطوف الثاني على المعطوف الأوّل.
وهكذا قد حكى الأولَ شيخُنا البهائي في بعض كلماته عن بعض النحاة.
وعلى أي حال مقتضاه استقلال كل من الفقرات الثلاث في ممانعة حمل التكبير على الركعتين ، مع أن الاستدلال بالمجموع ، فكان المناسب أن يقول : والظاهر من صدر الحديث ، وكذا يقول : والظاهر من سياقه.
اللهم إلّا أن يكون «أن» في قوله : «وأن الظاهر من صدره» ، وكذا في قوله : «وأن الظاهر من سياقه» بالكسر(١) .
لكنه خلاف الظاهر.
وتقريب الاستدلال : أن صدر الحديث نصٌ على تأخر الصلاة عن الإيماء ، والظاهر من صدر الحديث كفاية مطلق الإيماء واللعن ، والظاهر من سياق الحديث
__________________
(١) أي تكون «إن» وليس «أن» في كلا الموردين.
أن علقمة لما سمع المضمون المذكور النص في تأخر الصلاة عن الإيماء ، والظاهر في كفاية مطلق الإيماء واللعن استدعى دعاء يدعوا به عند الإيماء ودعاء يلعن به ، فأجاب بما أجاب ، فالجواب مبني على بيان فرد أكمل ، فلابد من تقديم الإيماء واللعن على الركعتين أيضاً قضية كون الجواب بياناً للفرد الأكمل على الوجه المتقدم ، والمفروض في الوجه المتقدم تقدم الإيماء واللعن ، ولو حمل التكبير على الركعتين فلابد من كون الإيماء المذكور في الجواب متأخراً عن الركعتين ، وهو خلاف المفروض في الوجه المتقدم ، فيتأتى التنافي بين الصدر والذيل ، إذ مدلول الصدر تقدم الإيماء على الركعتين ومدلول الذيل تقدم الركعتين ، فلا مجال لحمل التكبير على الركعتين ، والمانع منه موجود بخلاف الركعتين على التكبير ، فإنه لا مقتضي يقتضيه.
لكن نقول :
أوّلاً : إن الوجه المذكور مبني على أمرين :
أحدهما : حضور علقمة في مجلس مخاطبة أبي جعفر عليه السلام لعقبة ، ويرشد إليه قول عقبة : «أدعوا به في ذلك اليوم» قضية الإشارة ، حيث إن الظاهر كونها إشارة إلى اليوم المسبوق في المخاطبة ، ويرشد إليه أيضاً الفاء في قوله : «فقلت» في رواية «كامل الزيارة» ، حيث إن مقتضاها كون السؤال عقيب المخاطبة.
إلّا أن يقال : إن المخاطبة في رواية كامل الزيارة كانت مع مالك الجهني أو مع علقمة وكون سؤال علقمة بعد مخاطبة أو بعد مخاطبة مالك لا يقتضي ولا يقضي كون سؤال علقمة بعد مخاطبة والده أيضاً ، نعم بناءً على كون الراوي في رواية «المصباح» عن أبي جعفر عليه السلام هو علقمة كما هو مقتضى أحد الطريقين يتأتى إرشاد الفاء في قوله : «فقلت» في رواية «كامل الزيارة» ، وأما لو كان الراوي هو مالك الجهني كما هو مقتضى الطريق الآخر فلا يتأتى الإرشاد.
وثانيهما : موافقة الذيل للصدر في رواية «المصباح» بكون قوله : «فقل» معطوفاً على قوله : «أن تومئ» ، وانحصار ما يقتضي تقدم الصلاة على الزيارة في ذيل رواية «كامل الزيارة» ، إذ لو كان قوله : «فقل» جواباً للشرط فمقتضاه أيضاً تقدم الصلاة على الزيارة ، وهذا ينافي صدر هذه الرواية ، أعني رواية «المصباح» أيضاً ، كما أنه ينافي صدر رواية «كامل الزيارة» ، وكذا فعْل صفوان المروي في «المصباح» ، فلا يختص المنافاة بين صدر رواية «المصباح» وذيلها بحمل التكبير على الركعتين.
لكن يندفع الوجه الثاني بما تقدم من أن الظاهر كون قوله : «فقل» جواباً للشرط ، فبحمل الركعتين على التكبير لا ينافي الجمع بين رواية «كامل الزيارة» صدراً وذيلاً وكذا رواية «المصباح» صدراً وذيلاً وكذا فعل صفوان.
وأما الوجه الأوّل فتحقيق الحال وتفصيل المقال : أن مقتضى أول طريقي «كامل الزيارة» أن سيف بن عميرة وصالح بن عقبة رويا عن علقمة أن مولانا أبا جعفر عليه السلام قال مخاطباً إليه ما قال ، إلى أن روى سيف بن عميرة وصالح بن عقبة عن علقمة أنه سأل من أبي جعفر عليه السلام ، فأجاب أبو جعفر عليه السلام بما أجاب ، وعلى هذا يمكن أن يكون الأمر باتحاد مجلس مخاطبة أبي جعفر عليه السلام مع مالك وسؤال علقمة عن أبي جعفر عليه السلام وجوابه عنه ، كما ربما يرشد إليه الإشارة في سؤال علقمة بقوله : «في ذلك اليوم» لظهوره في سبق اليوم في المخاطبة ، ويرشد إليه أيضاً الفاء في قول علقمة : «فقلت» إذ مقتضاه كون السؤال عقيب المخاطبة ، وكذا اتحاد مجلس نقل مالك واقعته مع نقل علقمة ما وقع له من السؤال والجواب بأن كان سيف بن عميرة وصالح بن عقبة حاضرين في مجلس حضر فيه مالك وعلقمة ، فروى مالك واقعته فروى علقمة ما وقع له بعد واقعة مالك ، وهذا لا بأس به ، لكن انفراد صالح في نقل واقعة مالك وانضمام سيف بن عميرة في نقل واقعة علقمة بعيد ، فالظاهر سقوط سيف بن عميرة في نقل الطريق ، أي نقل واقعة مالك.
اللّهمّ إلّا أن يكون سيف بن عميرة غير حاضر عند نقل مالك قضيته وحضر عند
نقل علقمة ما وقع له ، أو كان حضر في أواسط نقل مالك واقعته فلم ينقل [إلّا] ما حضر نقله وسمعه لعدم النفع في نقله.
ويمكن أن يكون الأمر باختلاف المجلس الأوّل مجلس نقل مالك مغاير مع مجلس نقل علقمة مع اتحاد المجلس الثاني بأن يكون مجلس مخاطبة أبي جعفر عليه السلام مع مالك مغايراً مع مجلس سؤال علقمة عنه وجوابه عنه ، لكن مجلس نقل مالك مغايراً مع مجلس نقل علقمة ، وهذا مخالف لظاهر الإشارة والعطف بالفاء في «فقل» مضافاً إلى ما فيه من حديث ، بعد اختلاف حال سيف بن عميرة وصالح بن عقبة بالانضمام في المجلس الثاني والانفراد في المجلس الأوّل.
ويمكن أن يكون الأمر باختلاف المجلس الثاني مع اتحاد المجلس الأوّل بأن كان مالك نقل واقعته من دون نقل ما تقدم على واقعته من واقعة علقمة ، وكذا نقل علقمة في مجلسٍ آخر واقعته من دون نقل ما تقدم على واقعته من واقعة مالك مع اتحاد مجلس مخاطبة أبي جعفر عليه السلام مع مالك وسؤال علقمة من أبي جعفر عليه السلام.
وهذا بعيد ، إذ المدار في نقل الأخبار على اتصال الفوائد ، فكيف أمسك مالك عن نقل ما وقع بعد واقعته وأمسك علقمة عن نقل ما تقدم على واقعته ، بل بناء الناس في النقل والحكاية على استيفاء تمام الواقعة ولو في الواقع العرفية ، فالإمساك عن صدر الواقعة أو ذيلها مخالف للطريقة المتعارفة.
اللهم إلّا أن يكون مالك قد نقل واقعة علقمة أيضاً ونقل علقمة واقعة مالك أيضاً ، لكن روى صالح عن مالك ما وقع لنفسه وكذا نقل عن علقمة ما وقع لنفسه.
ويمكن أن يكون الأمر باختلاف كل من المجلسين ، وعلى هذا يتأتى ما سمعت من المحذور على تقدير اختلاف المجلس الأوّل واختلاف المجلس الثاني ، وعلى منوال حال أول الطريقين حال طريق «المصباح» لو كان الرواي عن أبي جعفر عليه السلام هو علقمة كما هو مقتضى ما سمعت من الوسائل والسيّد الداماد ، وعلى منوال حال
ثاني الطريقين حال ذلك ، أعني طريق «المصباح» لو كان الراوي عن أبي جعفر عليه السلام هو عقبة.
وبعد هذا أقول : إنه لو استدعى علقمة عن أبي جعفر عليه السلام تعليم الدعاء له بعد مخاطبة أبي جعفر عليه السلام كما هو مقتضى أول طريقي كامل الزيارة أو بعد مخاطبة مالك أو عقبة فلا مجال لتكرار الاستدعاء ، فلا يتأتى صدق ما عدا طريق واحد ، فدعوى حضور علقمة حين مخاطبة عقبة ، محل الكلام والإشكال.
وثانياً (١) : نقول : إنه وإن تمانع ما ذكر عن حمل التكبير على ظاهره لكن إطلاق الجزء على الكل غير عزيز وأما إطلاق الكل على الجزء كما في إطلاق الركعتين على التكبير فلعله نادر ، قيل إن استعمال الركعتين في التكبير مجاز بعيد في غاية البعد ، بل يمكن دعوى القطع بعدمه ، وهذا مجاز بعيد عن الاستعمالات والأذهان يقرب إلى هجانة استعماله وركاكة إطلاقه.
وثالثاً : نقول : إن التكبير الذي يكون جزء هو تكبيرة الإحرام لا التكبيرات المستحبة ، كيف وخروج التكبيرات الست الافتتاحية ظاهر ، فليس مطلق التكبير من باب الجزء.
ورابعاً : نقول : إن تكبيرة الإحرام لا توجد في مطلق الركعتين ، كيف والأخيرتان من الرباعيتين خاليتان عن تكبيرة الإحرام.
إلّا أن يقال : إن المقصود من الركعتين هو الصلاة الثنائية ، وهي مشتملة على تكبيرة الإحرام ، وفيه الكفاية وإن لم يكن التكبير جزء لمطلق الركعتين.
وخامساً : نقول : إن إطلاق الكل على الجزء في غير المركب الحسي أعني المركب الاعتباري غير ثابت ، فلا يتأتى جواز استعمال الركعتين في التكبير.
__________________
(١) عطف على قوله فيما تقدّم: «لكن نقول أوّلاً».
قال المحقّق القمّي : «وجدنا أنهم يستعملون اللفظ الموضوع للكل في الجزء إذا كان المركب مركباً حقيقياً ، كاستعمال الأصابع في الأنامل في قوله تعالى : ( يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم) (١) واليد في الأصابع إلى نصف الكفّ في آية السرقة(٢) ، وإلى المرفق في آية الوضوء(٣) ، وإلى الزند في آية التيمم(٤) ، فلا يجوز القياس في غير المركبات الحقيقية»(٥) .
هذا بناء على القول بالوضع في المجازات ، وأما على القول بكونها عقلية ، كما هو الأظهر نقول : إنه لا يتأتى الملاحة المعتبرة في المركب الاعتباري.
وقد يورد تارة : بأن علاقة الكل والجزء في التجوز في المركب هنا فاقدة لشرطها.
وفيه : أنه لم يُذكر لاستعمال الكل في الجزء شرط.
نعم قد ذُكِرَ اشتراط استعمال الجزء في الكل بأن يكون للجزء المطلق على الكل مزيد اختصاص بالمعنى الذي قصد بالكل ، والغرض أن يكون للجزء المطلق على الكل زيادة مداخلة في استيفاء الغرض من الكل ، والظاهر أن الإيراد مبنى على الاشتباه بين إطلاق الكل على الجزء وإطلاق الجزء على الكل.
اللهم إلّا أن يكون الغرض اشتراط كون التركيب حسياً.
وأخرى : بأن المناسب للتجوز بعلاقة الكل والجزء هو التجوز في الركعة والصلاة لا الركعتين.
__________________
(١) البقرة ٢: ١٩.
(٢) وهي قوله تعالى: ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) المائدة ٥: ٣٨.
(٣) وهي قوله تعالى: ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة ٥: ٦.
(٤) وهي قوله تعالى: ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ) النساء ٤: ٤٣.
(٥) قوانين الأصول: ٦٤.
وفيه : إنه لا بأس بالتجوز بالركعتين أيضاً.
وثالثة : بأن التجوز لابد له من قرينة وجعل القرينة ما في «المصباح» من غرائب الكلام ، إذ المستعمل الإمام ، فكيف يكون ما في «المصباح» قرينة لكلام الإمام عليه السلام.
وفيه : إن هذا الكلام أولى بأن يعد من غرائب الكلام إذ الغرض كون القرينة كلام الإمام المذكور في «المصباح» ، كيف وفي الأخبار أن الأخبار يكشف بعضها عن بعض.
قوله : «ومنها أن المدلول عليه بصدر الحديث» مقصوده أن مقتضى صدر الحديث اختتام الزيارة بالركعتين ومقتضى حمل التكبير في الذيل على الركعتين تعقب الركعتين بالزيارة ، وهذا ينافي مدلول الصدر ، فهو يمانع عن حمل التكبير على الركعتين ، إذ على تقدير حمل التكبير على ظاهره يتأتى الاختتام بالركعتين.
لكن يتطرق الإيراد عليه بما يظهر ممّا مرّ من حديث ندرة إطلاق الكل على الجزء ، بل عدم الإطلاق ، بخلاف إطلاق الجزء على الكل ، مع أنه على تقدير حمل التكبير على ظاهره يتأتى التنافي أيضاً ، نظير التنافي في المتأتي على تقدير الحمل على الركعتين ، حيث إنه على تقدير حمل التكبير على ظاهره يكون مقتضى الصدر كون ابتداء الزيارة بالإيماء ، ومقتضى الذيل كون الإيماء مسبوقاً بالتكبير ، غاية الأمر أن هذا التنافي إنما يكون في الإبتداء ، والتنافي المتأتي على تقدير حمل التكبير على الركعتين إنما يكون في الإنتها ، وهذا الاختلاف لا يوجب رجحان الأوّل ، فليس التنافي في الابتداء المتأتي على تقدير حمل التكبير على الركعتين راجحاً على التنافي المتأتي على تقدير حمل التكبير على ظاهره.
قوله : «ومنها أن مقتضى هذا الحمل ..» مقصوده أن مقتضى حمل التكبير على الركعتين إناطة الزيارة بالإيماء بعد الركعتين كما ينوط بالإيماء قبل الركعتين ،
وهذا ينافي الصدر ، بخلاف حمل التكبير على ظاهره ، فإن مقتضاه كفاية الإيماء قبل الركعتين ، كما هو مقتضى الصدر.
وينقدح مضافاً إلى ما يظهر ممّا مرّ ممّا تقدم من ندرة إطلاق الكل على الجزء بخلاف إطلاق الجزء على الكل ، بأنه على تقدير حمل التكبير على ظاهره يتأتى أيضاً نظير ما ذكر حيث إنه على تقدير حمل الكتبير على ظاهره يكون مقتضاه إناطة الزيارة بالتكبير قبل الإيماء ، وهذا ينافي مدلول الصدر بخلاف الحمل على الركعتين ، فإن مقتضاه كفاية الإيماء في الابتداء ، كما هو مقتضى الصدر مع أن هذا الوجه عبارة أخرى للوجه السابق حيث إنه لو كان مقتضى الصدر اختتام الزيارة بالركعتين لكان مقتضاه كفاية الإيماء قبل الركعتين ولو كان مقتضى الذيل إناطة الزيارة بالإيماء بعد الركعتين على تقدير حمل التكبير على ظاهره يكون مقتضاه عدم اختتام الزيارة بالتكبير بالركعتين.
قوله : «ومنها أنه لو حمل التكبير ..» مقصوده الاستناد إلى فهم سيف بن عميرة تأخر الصلاة عن الزيارة في كلام رواه علقمة عن أبي جعفر عليه السلام برواية كامل الزيارة و «المصباح» ، قضية عدم مضايقته عما فعله صفوان وهو قد أخّر الصلاة عن الزيارة إلّا في باب الدعاء المبدوء بـ: يا اللهُ يا اللهُ ، على حمل التكبير على الركعتين لاقتضاء حمله على ظاهره تأخر الزيارة عن الصلاة ، حيث إن فهم الرواي مرشد كامل في فهم الأخبار.
ويظهر الكلام فيه بما مرّ ، كما نقول إن الرواي كثيراً ما يخطأ في الفهم بشهادة استنكار المعصوم عليه السلام عمّا فهمه الراوي في موارد متعددة قد أخطأ الراوي في فهم المراد فيها وإن كان الظاهر مطابقاً في غالب تلك الموارد لما فهمه الراوي ، ويرشد إليه ما رواه في «الكافي» في باب طلب الرياسة بالإسناد عن أبي حمزة الثمالي ، قال : «قال أبو عبدالله عليه السلام :إيّاك والرياسة ، وإيّاك وأن تطأ أعقاب الرجال.
قلت : جعلت فداك ، أمّا الرياسة فقد عرفتها ، وأمّا أن أطأ أعقاب الرجال فما ثلثا
ما في يدي إلّا مما وطئت أعقاب الرجال.
فقال :ليس حيث تذهب ، إيّاك أن تنصّب رجلاً دون الحجّة فتصدّقه في كلّ ما قا ل»(١) .
قوله(٢) : «ثلثا» ، أي سهمان من ثلاثة.
وكذا ما رواه في الكافي في باب الكِبْر بالإسناد عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال :لا يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال حبّة من خردل من الكِبْر .
قال : فاسترجعت.
فقال :ما لك تسترجع؟
قلت : لما سمعت منك.
فقال :ليس حيث تذهب ، إنّما هو الجحود »(٣) .
وكذا ما رواه في «الكافي» في كتاب الصلاة في باب ما يقبل من صلاة الساهي ، بالإسناد عن محمّد بن مسلم ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنّ عمار الساباطي روى عنك رواية.
فقال :ما هي؟
قلت : إنّ السنّة فريضة.
__________________
(١) اُصول الكافي : ٢ : ٢٩٨/٥.
وممّا اُستند فيه إلى فهم الراوي قول عمّار في الموثّق: «وصف لي أبو عبدالله عليه السلام المطبوخ كيف يطبخ حتّى يصير حلالاً ، فقال لي عليه السلام: خذ ربعاً من زبيب» ، حيث إنّ مقتضاه أنّ عمّاراً فهم من كلام الإمام أنّ الطبخ ـ أعني ذهاب ثلثين ـ بحمل مقتضاه حرمة عصير الزبيب قبل ذهاب الثلثين. منه عفي عنه.
(٢) المراد به ما تقدّم ذكره في الرواية الآنفة الذكر.
(٣) اُصول الكافي: ٢: ٣١٠/٧.
قال :أين يذهب ، أين يذهب ، ليس هكذا حدّثته ، إنّما قلت له : من صلّى فأقبل على صلاته ولم يحدّث نفسه فيها ، أو لم يسه فيها ، أقبل الله عليه ما أقبل عليها ، فربما رفع نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها ، إنّما أمرنا بالسنّة لتكمل بها ما ذهب من المكتوبة »(١)
قوله : «السنّة فريضة» أي النافلة واجبة.
قال المحقّق القمّي في بعض مباحث أخبار الآحاد : «إنّ عمار الساباطي مع كثرة رواياته وشهرتها لا يخفى على المطّلع برواياته ما فيها من الاضطراب والتهافت الكاشفَين عن سوء فهمه وقلّة حفظه.
قال : وممّا يشهد به ما رواه عن الصادق عليه السلام في وجوب النوافل اليومية ، ولما عرض عليه عليه السلام قال : أين يذهب ، ومقصوده بما رواه عمّار عن الصادق عليه السلام في وجوب النوافل اليوميّة هو الرواية المذكورة»(٢) .
وكذا ما في «الكافي» في كتاب الأطعمة في باب فضل اللحم ، بالإسناد عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام : إنّ رجلاً قال له : إنّ من قِبلنا يروون أن الله عزّ وجلّ يبغض البيت اللحم.
فقال: صدقوا ، وليس حيث ذهبوا. إن الله يبغض البيت الذي فيه يؤكل لحوم الناس »(٣) .
قوله : «يروون» أي عن رسول الله صلى الله عليه وآله كما هو مقتضى السؤال في طائفة من الأخبار.
__________________
(١) فروع الكافي: ٣: ٣٦٣/١.
(٢) نسب هذا الكلام للمحقّق القمّي في القوانين على ما في سماء المقال ، إلّا أنّه بعد مراجعة القوانين لم نعثر على شيء من ذلك ، فراجع سماء المقال: ٢: ١٠٣.
(٣) فروع الكافي: ٦: ٣٠٩/٦.
لكن روي في «الوسائل» عن البرقي عن ابن محبوب ، عن حماد بن عثمان ، أنه قال : «قلت لأبي عبد الله عليه السلام : البيت اللحم يكره؟
قال : ولِمَ؟
قلت : بلغنا عنكم ...»(١) .
وبمضمونه رواية أخرى رواها في «الوسائل» عن البرقي أيضاً(٢) .
قوله : «يبغض بيت اللحم» ، أي البيت الذي يؤكل فيه اللحم كلّ يوم.
وبمضمون تلك الرواية رواية بل روايات أخرى ، ومقتضى الكلّ أن النبيّ صلى الله عليه وآله قال : : «إنّ الله عزّ وجلّ يبغض البيت اللحم » ، وأخطأ من سمعه في فهم المراد عملاً بظاهر الكلام ، لكن مقتضى بعض الأخبار أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال : «إن الله يبغض البيت الذي يغتابون فيه الناس ويأكلون لحومهم » ، وكذب من أسند إليه صلى الله عليه وآله أنّ الله يبغض البيت اللحم(٣) .
وكذا ما في «الكافي» في باب كسب الماشطة والخافظة بالإسناد عن سعد الإسكاف ، قال : «سئل أبو جعفر عليه السلام عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهنّ تصلن به شعورهنّ؟
فقال : لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها.
قال : فقلت : له : بلغنا أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة
فقال :ليس هناك ، إنّما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة التي تزني في شبابها ، فلمّا كبرت قادت النساء على الرجال ، فتلك الواصلة والموصولة »(٤) .
__________________
(١) وسائل الشيعة: ٢٥: ٣٨ ، الباب ١١ من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث ١١.
(٢) المصدر السابق: الحديث ١٢.
(٣) فروع الكافي: ٦: ٣٠٨/٥ ، ولا يخفى أنّ نقله للحديث هنا بالمعنى.
(٤) فروع الكافي: ٥: ١١٩/٣.
قوله : «القرامل». قال في «النهاية» نقلاً : «القرامل : هي صغائر من صوف أو شعر أو أبريسم تصل به المرأة شعرها».
وكذا ما في «الكافي»(١) في باب استحباب الجهر بالبسلمة بالإسناد عن صباح الحذاء ، عن رجل ، عن أبي حمزة ، قال : «قال عليّ بن الحسين عليهما السلام :يا ثمالي ، إنّ الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الإمام فيقول هل ذكر ربّه؟
فإن قال : نعم ، ذهب ، وإن قال : لا ، ركب على كتفه ، فكان إمام القوم حتّى ينصرفوا.
قال : فقلت : جعلت فداك ، أليس يقرؤون القرآن؟!
قال :بلى ، ليس حيث تذهب يا ثمالي ، إنّما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم »(٢)
قوله عليه السلام : «هل ذكر ربه» ، أي جهر بالتسمية.
قوله : «فإن قال : نعم ، ذهب» لأنه يعلم أن بناء المصلي على الجهر بالتسمية فيذهب لكي لا يطرد بالجهر بالتسمية بعد ذلك.
قوله : «وإن قال : لا ، ركب » لأنه يعلم أن بناء المصلي على إسرار التسمية فليس ما يطرده فلا يذهب.
قوله : «ليس حيث يذهب » أي ليس الغرض من ذكر الرب مطلق ما كان ذكر الله ، بل الغرض الجهر بالتسمية.
وكذا في «معاني الأخبار» في معنى قول الصادق عليه السلام : «من طلب الرياسة هلك » ، بالإسناد عن سفيان بن خالد ، قال : «قال أبو عبد الله عليه السلام :إيّاك والرياسة ، فما طلبها أحد إلّا هلك.
__________________
(١) الصحيح في التهذيب ، وليس في الكافي.
(٢) تهذيب الأحكام: ٢: ٢٩٠/١٨.
فقلت له : جعلت فداك ، هلكنا إذ ليس أحد منّا إلّا وهو يحبّ أن يُذكر ويُقصد ويُؤخذ عنه.
فقال :ليس حيث تذهب ، إنّما ذلك أن تنصّب رجلاً دون الحجّة فتصدّقه في كلّ ما قال ، وتدعو الناس إلى قوله »(١) .
وكذا ما في «معاني الأخبار» في باب معنى قول الصادق عليه السلام : «من دخل الحمّام فلير عليه أثره» ، بالإسناد عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه رفعه ، قال : «نظر أبو عبد الله عليه السلام إلى رجل قد خرج من الحمّام مخضوب اليدين.
فقال له أبو عبد الله عليه السلام :أيسرّك أن يكون الله عزّ وجلّ خلق يديك هكذا؟
قال : لا ، والله إنّما فعلت ذلك لأنّه بلغني أنّه من دخل الحمّام فلير عليه أثره ، يعني الحنّاء.
فقال :ليس حيث ذهبت ، إنّما معنى ذلك : إذا خرج أحدكم من الحمّام وقد سَلِمَ فليصلِّ ركعتين شكراً »(٢) .
وكذا ما في «معاني الأخبار» في باب معنى قول العالم عليه السلام : «عورة المؤمن على المؤمن حرام» ، بالإسناد عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : «قلت له : عورة المؤمن على المؤمن حرام؟
قال :نعم.
قلت : يعني سفليه؟
قال :ليس هو حيث تذهب ، إنّما هو إذاعة سرّه »(٣) .
__________________
(١) معانى الأخبار: ١٨٠ ، الحديث ١.
(٢) معاني الأخبار: ٢٥٤ ، الحديث ١.
(٣) معاني الأخبار: ٢٥٥ ، الحديث ٢.
وكذا ما في «معاني الأخبار» في الباب المذكور بالإسناد عن حذيفة بن منصور ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يروى : عورة المؤمن على المؤمن حرام؟
قال :ليس حيث تذهب ، إنّما عورة المؤمن أن تراه يتكلّم بكلام يعاب عليه فتحفظه عليه لتعيّره به يوماً إذا غضب »(١) .
وكذا ما في «التهذيب» في كتاب الصلاة في باب فضل شهر رمضان والصلاة فيه زياده على النوافل المذكورة في سائر الشهور ، بالإسناد عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : «يصلّى في شهر رمضان زيادة ألف ركعة .
قلت : ومن يقدر على ذلك.
قال :ليس حيث تذهب ، أليس يصلّى في شهر رمضان ألف ركعة في تسع عشرة منه ، في كلّ ليلة عشرين ركعة ، وفي ليلة تسع عشرة مائة ركعة ، وفي ليلة إحدى وعشرين مائة ركعة ، وفي ليلة ثلاث وعشرين مائه ركعة ، ويصلّى في ثمان ليال منه في العشر الأواخر ثلاثين ركعة ، فهذه تسعمائة وعشرون ركعة .
قلت : جعلني الله فداك ، فرّجت عنّي ، لقد كان ضاق بي الأمر ، فلمّا أن أتيت لي بالتفسير فرّجت عنّي ، فكيف تمام الألف ركعة؟
قال :تصلّي في كلّ يوم جمعة من شهر رمضان أربع ركعات لأمير المؤمنين عليه السلام ، وتصلّي ركعتين لابنة محمّد عليها السلام إلى آخر الحديث»(٢) .
وكذا ما في «التهذيب» في كتاب الصوم في باب ما يفسد الصائم وما يخل بشرائط فرائضه وما ينقض الصيام ، بالإسناد عن أبي بصير ، قال : «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم.
__________________
(١) معاني الأخبار: ٢٥٥ ، الحديث ٣.
(٢) تهذيب الأحكام: ٣: ٦٦/٢١.
قال : قلت : هلكنا.
قال :ليس حيث تذهب ، إنّما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام »(١) .
وكذا ما في «الوسائل» في كتاب الزكاة في باب استحباب الصدقة في الليل عن العلل ، بالإسناد عن سفيان بن عيينة(٢) ، قال : «رأى الزهري عليّ بن الحسين عليهما السلام ليلة [باردة مطيرة] وعلى ظهره دقيق وحطب وهو يمشي ، فقال له : يا بن رسول الله ، ما هذا؟
قال :اُريد سفراً اُعدّ له زاداً أحمله إلى مكان [موضع] حريز إلى أن قال : فلمّا كان بعد أيام قال له : يا بن رسول الله ، لست أرى لذلك السفر الذي ذكرته أثراً؟
قال :بلى يا زهري ، ليس ما ظننت ولكنّه الموت ، وله كنت أستعد ...»(٣) .
وكذا ما في «الوسائل» في كتاب القضاء ، [عن «معاني الأخبار» ، و] عن «العلل» بالإسناد عن ابن أبي عمير ، عن عبد المؤمن الأنصاري ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنّ قوماً رووا أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال :إنّ اختلاف أُمّتي رحمة.
فقال : صدقوا.
فقلت : إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب؟
قال : ليس حيث تذهب وذهبوا ، إنّما أراد قول الله عزّ وجلّ : ( فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ( (٤) فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فيتعلّموا ثمّ يرجعوا إلى قومهم
__________________
(١) تهذيب الأحكام: ٤: ٢٠٣/٢.
(٢) في كتاب الزكاة في باب استحباب الصدقة في الليل عن العلل: بالإسناد عن سفيان بن عيينة ، بالعين المهملة المضمومة والمثناتين من تحت ومنّون. منه عفي عنه.
(٣) وسائل الشيعة: ٩: ٤٠١ ، الباب ١٤ من أبواب الصدقة ، الحديث ٥.
(٤) التوبة ٩: ١٢٢.
فيعلموهم ، إنّما أراد اختلافهم من البلدان لا اختلافاً في دين الله ، إنّما الدين واحد ، إنّما الدين واحد ، إنّما الدين واحد »(١) .
ولكن يمكن أن يقال : إنّ الظاهر والغالب الإصابة وبروز الخطأ في بعض الأحيان لا يوجب رفع الظن كما أن بروز الكذب عن الشخص في بعض الأوان لا يوجب رفع الظنّ بصدقه أو رفع الظن بصدق أمثاله فيما لم يثبت الكذب فيه ، وكما أن بروز
__________________
(١) وسائل الشيعة: ٢٧: ١٤٠ ، الباب ١١ من أبواب القاضي ، الحديث ١٠.
وقد روي في الكافي والفقيه بالإسناد عن أبي بصير ، قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام فقلت: متى يحرم الطعام والشراب على الصائم ، وتحلّ الصلاة صلاة الفجر؟
فقال: إذا اعترض الفجر وكان كالقبطيّة البيضاء، فثمّ يحرم الطعام ويحلّ الصيام وتحلّ الصلاة صلاة الفجر
قلت: فلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟
فقال:هيهات، أين تذهب تلك صلاة الصبيان ».
قوله: «كالقبطيّة » ـ بكسر القاف وسكون الباء الموحدة وتشديد الياء ـ منسوبة إلى القبط ، ثياب بيض رقاق تتّخذ بمصر ، وقد يضمّ القاف ، نظير: سهلى ودهرى ، كما يقتضيه كلام صاحب الصحاح.
وعن شيخنا البهائي: «القبط: بكسر القاف».
وذكر في القاموس: أنّ القبط ـ بالكسر ـ أهل مصر ، وإليه ينسب الثياب القبطيّة ، وبالضمّ على غير قياس.
وذكر في المغرب نقلاً: أنّ القبطي ـ بضمّ القاف ـ واحد القباطي ، وهي ثياب بيض دقيقة رقيقة تعمل وتتّخذ بمصر ، نسبت إلى القبط بالكسر والتبعيّة ، كما في دهرى نسبة إلى الدهر ـ بالفتح ـ. يقال: رجل قبطي بالكسر على الأصل.
قوله: «في وقت» أي وقت الصلاة.
وبعد فالأمر في الحديث ليس من باب حمل اللفظ على خلاف المراد. ذكرناه من باب المناسبة والمشابهة. منه رحمه الله.
التجوز في بعض المواضع لا يوجب الفتور في ظهور الحقيقة لا في كلام المتجوز ولا في كلام غيره فيما لم يثبت فيه الحال ، فالاستناد إلى فهم سيف بن عميرة لا بأس به بنفسه.
إلّا أنّه يتطرّق الكلام بما مرّ.
وبعد ما مرّ أقول : إنّه كان المناسب له الاستناد في عدم جواز حمل التكبير على الركعتين بأن مقتضى صدر رواية «كامل الزيارة» وكذا صدر رواية «المصباح» ، وكذا فعل صفوان رواية عن الصادق عليه السلام تأخّر الصلاة عن الزيارة ولو حمل التكبير على الركعتين يصير مقتضاه تأخر الزيارة عن الركعتين ، وهو مخالف لما ذكر بخلاف ما لو حمل على ظاهره ، فإنّه يصير مقتضاه تأخر الصلاة عن الزيارة ، وهو موافق لما ذكر فهو الأرجح.
قوله : «فلابد من حمل الركعتين على التكبير» لا يذهب عليك أنّه لو تمّ التمسّك بالوجوه المتقدّمة إنّما يتمّ في عدم حمل التكبير على الركعتين ، لكن لا يتأتّى منها لزوم حمل الركعتين على التكبير ، كيف وهو قد احتمل السهو في الركعتين ، بل الحمل على السهو أولى وأقرب من حمل الركعتين على التكبير لعدم اتّفاق مثل استعمال الركعتين في التكبير في الأخبار وقوة احتمال السهو والنسيان في الإنسان.
قوله : «لأن قلت» في قوله : «وقلت عند الإيماء إليه» عطف على «تومئ»
قد ظهر فيما تقدم فساد هذا الوجه لفظاً ومعنى.
وإن قلت : إن فساد المعنى إنما يلزم على تقدير كون الغرض اتحاد الزيارة والصلاة ، وأما لو كان الغرض تعدد الزيارة والصلاة فلا يلزم فساد المعنى.
قلت : إنه لو كان الغرض تعدد الزيارة والصلاة يلزم مخالفة الذيل للصدر لاقتضاء الصدر كفاية وحدة الزيارة والصلاة واقتضاء الذيل تعدد الزيارة والصلاة.
اللهم إلّا أن يبنى على تعدد الزيارة والصلاة ، لكنه خلاف ما يقتضيه الصدر
من كفاية وحدة الزيارة والصلاة وعدم الحاجة إلى التعدّد مع أن مقصوده التوفيق بين الصدر والذيل.
قوله : «مخالفاً للصدر لاقتضاء الصدر» ، أعني قوله عليه السلام : «وأومئ إليه بالسلام واجتهد على قاتله بالدعاء وصلى بعده ركعتين » ، كون الركعتين في آخر الأمر واقتضاء الذيل ، أعني قوله : «وقلت عند الإيماء إليه بعد الركعتين هذا القول» كون الزيارة بعد الركعتين.
قوله : «وذيله» ، أي حكاية سيف بن عميرة مع صفوان لاقتضاء الذيل كون الركعتين في آخر العمل واقتضاء قوله عليه السلام : «وقلت ...» ، كون الزيارة بعد الركعتين ، لكنّك خبير بأن واقعة سيف بن عميرة مع صفوان واقعة في رواية «المصباح» ، وأما «كامل الزيارة» فهو خال عن تلك الواقعة.
قوله : «وأمّا على تقدير ذكر كلمة من» ، فكذلك كما لا يخفى لوضوح اقتضاء قوله : «وقلت» تأخر الزيارة عن الركعتين وهو خلاف ما يقتضيه الصدر بناء على ما زعمه من اشتمال رواية «كامل الزيارة» على واقعة سيف بن عميرة مع صفوان.
وبعد هذا أقول : إنّ الوجه المذكور بعد ضعفه بما يظهر ممّا سمعت آنفاً من أن غاية الأمر لزوم حمل الركعتين على التكبير أو السهو ، ولا يتعيّن الأوّل يضعف بما سمعت الإيراد به سالفاً من ندرة التجوز بالكلّ عن الجزء واحتمال السهو في الركعتين كما ذكره ، فلا ينتهض البناء على التجوز في الركعتين عن التكبير كما هو مقتضى كلامه.
وبما تقدّم ينهدم بنيان ما جرى عليه بعض الأعلام المتقدّم من كون المدار على التكبير مرّات متعدّدة ، وإن كان الأحوط مائة مرّة بملاحظة ما ذكره الكفعمي(١)
__________________
(١) في كتابة جنّة الأمان الواقية وجنّة الإيمان الباقية ، المشهور بالمصباح: ٥٦٤.
من اعتبار مائة مرّة والزيارة من السلام إلى السجدة ودعائها ، حيث إن الابتداء فيه بالتكبير مبني على جعل قوله عليه السلام : «فقل» في رواية «المصباح» معطوفاً على قوله عليه السلام : «تومئ » ، وقد مر تضعيفه ، وتقديم الزيارة فيه على الصلاة مبني على حمل الركعتين في رواية «كامل الزيارة» على التكبير ، وقد مرّ تزييفه.
وربّما جرى بعض أيضاً على طرح الاتّحاد بين ذيل رواية «كامل الزيارة» وصدر رواية «المصباح» وفعل صفوان بكون «بعد ُ» مبنيّاً على الضمّ مضافاً إلى محذوف ، نحو : ( قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ) (١) ، وكون الركعتين إما مفعولاً لـ (صليت) المقدّر هاهنا لوضوحه ودلالة القرينة عليه أو نحو ذلك ، ومقتضاه كون قوله عليه السلام : «من بعد الركعتين » أو بإسقاط الواو جملة معترضة في البين ، وربما يشعر به قوله عليه السلام : «وصلّى من بعدُ ركعتين » في رواية «المصباح»(٢) ، لكون «بعد» فيه مبنيّاً على الضمّ.
لكن نقول : إنّ الوجه المزبور بعد عدم صحته لو كان النسخة : «بعدُ» بدون الواو و «من» ، فتدبّر(٣) في مخالفة الظاهر بمكان لا أحسب أن يتحقّق ما يكون أشدّ مخالفة للظاهر منه في مورد.
والبعض المذكور جرى على طرح الاتّحاد أيضاً بين ذيل رواية «المصباح» وصدرها ، وصدر رواية «المصباح» وصدرها ، وصدر رواية «كامل الزيارة» وفعل صفوان بجعل قوله عليه السلام : «فقل » معطوفاً على قوله عليه السلام : «تومئ » ، بل جعل هذا
__________________
(١) الطور ٥٢ : ٢٦.
(٢) قوله: «في رواية المصباح» ، وكذا قوله عليه السلام: «وصلِّي بعد ركعتين » في صدر رواية كامل الزيارة على ما عندي من النسخة ، كما مرّ ، منه رحمه الله.
(٣) قوله: «فتدبّر» إشارة إلى إمكان اطّراد الوجه المشار إليه على تقدير كون النسخة بدون الواو ومن ، غاية الأمر كون المخالفة للظاهر أشد. منه رحمه الله.
ظاهراً ، وهو مدفوع بما تقدّم.
وجرى في «الدرّ المنثور»(١) على وجه نفي البعد على كون قوله عليه السلام في ذيل رواية «المصباح» : «فقل » محرّف «فقلت» بناء على أن المعهود المتعارف بين الإماميّة هو تأخير الصلاة عن الزيارة من باب طرح الإتحاد بين الذيل المذكور ، أعني ذيل رواية «المصباح» وصدرها وصدر رواية «كامل الزيارة» وفعل صفوان.
وأنت خبير بأن الوجه المذكور إن كان المقصود به مجرّد الاحتمال المساوي فلا عبرة به ، وإن كان الغرض الاحتمال القريب من باب انصراف المطلق إلى بعض الأفراد ، أعني انصراف نفي البعد إلى القرب فليس بشيء.
وقد بنى الكفعمي(٢) على أن المدار على الإيماء بالسلام المختصر والاجتهاد في اللعن على قاتل سيّد الشهداء والصلاة ركعتين والتكبير مائة مرّة والزيارة المشهورة بتمامها والصلاة ركعتين أيضاً ، لكنّه عبّر عنهما بركعتي الزيارة ، وظاهره كون الصلاة الثانية هي صلاة الزيارة وكون الصلاة الأولى من باب الاحتياط ، فالمرجع إلى القول بتأخر صلاة الزيارة عن الزيارة.
وربما احتمل أن تكون الركعتان الأوليان من باب استحباب الصلاة في مطلق الزيارة وأن تكون الركعتان الأوليان والركعتان الأخيرتان من باب استحباب الركعات الأربع في يوم عاشوراء ، كما أن في كلامه نوع إشارة إليه ، حيث إنه قال بعد دعاء الهدية : «ويستحب أن يصلّي أيضاً في يوم عاشوراء أربع ركعات».
أقول : إن كلام الكفعمي في باب البعيد(٣) وهو ساكت عن حال القريب ،
__________________
(١) ستأتي الإشارة إلى هذا الكتاب ومؤلّفه.
(٢) في كتابه جنّة الأمان الواقية وجنّة الإيمان الباقية ، المشهور بالمصباح :٥٦٤.
(٣) حيث إنّه قال ما نصّه: «فمن أراد ذلك ، وكان بعيداً عنه عليه السلام ، فليبرز إلى الصحراء ...».
والاحتمال الأوّل إنما ينتهض في حق البعيد لو ثبت استحباب الصلاة في مطلق الزيارة ولو في حقّ البعيد مقدمة على الصلاة ، وإلّا فلو لم يثبت استحباب الصلاة في مطلق الزيارة حتى زيارة عاشوراء أو ثبت الإطلاق المذكور ، لكن لم يتم شموله للبعيد أو تم شموله للبعيد ، لكن لم يتمّ تقدّم الصلاة على الزيارة في حقّ البعيد ، فلا يتمّ الاحتمال المذكور.
نعم ، مقتضى كلام ابن زهرة والسيّد الداماد ، بل الشهيد في «الذكرى» استحباب الصلاة في باب الزيارة مطلقاً كما يأتي ، لكن مقتضى كلامهم تقدّم الصلاة على الزيارة في حق البعيد ، وبعد انتهاض إطلاق استحباب الصلاة في مطلق الزيارة ولو في حق البعيد مقدّمة على الصلاة لا بدّ من تقييده بما دل على استحباب الصلاة في زيارة عاشوراء مؤخّرة عن الزيارة ، كما هو المفروض بناء على حمل المطلق على المقيد في المندوبات.
وأما الاحتمال الثاني فهو خلاف الظاهر إذ الظاهر من قوله : «أيضاً» في قوله : «ويستحب أن تصلّي أيضاً في يوم عاشوراء أربع ركعات» هو كون الصلاة الأربع المذكورة أخيراً غير الصلوات الأربع الاُولى ، وما ذكره المحتمل من أن قوله : «ويستحب أن يصلّي أيضاً في يوم عاشوراء أربع ركعات» نوع إشارة إلى كون الجمع بين الركعتين الأوليتين والركعتين الأخيرتين من باب استحباب الصلوات الأربع ، ظاهر الضعف.
وبالجملة قال الكفعمي : «وقل بعدهما ـ يعني الركعتين الأخيرتين ـ:
اللّهُمَّ إِنّي لَكَ صَلَّيْتُ ، وَلَكَ رَكَعْتُ ، وَلَكَ سَجَدْتُ ، وَحْدَكَ لَا شَريكَ لَكَ ، لِأَنَّهُ لَا يَجوزُ الصَّلَاةَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ إِلَّا لَكَ ، لِأَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ. اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَبْلِغْهُمْ أَفْضَلَ السَّلَامِ وَالتَّحِيَّةِ ، وَارْدُدْ عَلَيَّ مِنْهُمْ السَّلَامَ. اللّهُمَّ وَهاتانِ الرَّكْعَتانِ هَدِيَّةٌ مِنّي إِلى سَيّدي مَوْلَايَ
الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ. اللّهُمَّ صَلُّ عَلى مُحَّمَدٍ وَآلِهِ ، وَتَقَبَّلْهُما مِنّي ، وَأَجْزِني عَلَيْهِما أَفْضَلَ أَمَلي وَرَجائي فيكَ وَفي وَليِّكَ ، يا وَلِيَّ الْمُؤْمِنينَ.
فقال : ويستحبّ أن تصلّي أيضاً في يوم عاشوراء أربع ركعات ، وقد مر كيفية فعلهما في فصل الصلوات ، ثمّ ادع بعد هذه الزيارة هذا الدعاء المروي عن الصادق عليه السلام(١) وذكر دعاء الوداع ، أعني دعاء صفوان.
قوله(٢) : «ويستحب أن تصلّي أيضاً في يوم عاشوراء أربع ركعات» ظاهره بمقتضى ذكر دعاء الوداع بعد ذلك هو استحباب الإتيان بتلك الصلوات الأربع بعد الصلاة الثانية ، لكن ظاهر قوله : «ثمّ ادع بعد هذه الزيارة بهذا الدعاء» هو كون الدعاء بعد الزيارة من دون تخلل الركعات الأربع ، وعلى هذا يكون قوله : «ويستحب» من باب الجملة المعترضة ، لكنّه بعيد.
وبالجملة : فقد عدَّ في فصل الصلوات من الصلوات صلاة عاشوراء ، وحكاه عن ابن فهد في موجزه ، قال : «وصلاة عاشوراء أربع مفصولة يحسن ركوعها وسجودها ويقرأ في الاُولى بعد الحمد الجحد ، وفي الثانية التوحيد ، وفي الثالثة الأحزاب ، وفي الرابعة المنافقون أو ما تيسر ، ثمّ يسلّم ويحوّل وجهه نحو قبر الحسين عليه السلام ويزوره. قاله ابن فهد في موجزه»(٣) .
أقول : إن ظاهر كلامه أن ما ذكره بيان الكيفية الواقعية لا الاحتياط ، مع أنه لم يرد رواية تطبق ما ذكره ولم يذكره بطريق الرواية ، كيف والإشكال في عدم مداخلة كل من الصلاتين في الزيارة واقعاً ، ومع هذا لا دليل على ما ذكره من العدد في باب
__________________
(١) جنّة الأمان الواقية وجنّة الإيمان الباقية ، المشهور بالمصباح: ٥٦٧.
(٢) أي قول الكفعمي.
(٣) جنّة المأوى الواقية وجنّة الإيمان الباقية ، المشهور بالمصباح: ٤٧٥.
التكبير ومع هذا لو كان غرضه إدراج الصلوات الأربع بين الصلاة الأخيرة ودعاء الوداع فضعفه ظاهر ، إذ لا ريب في عدم دخولها في الزيارة ، فلا مجال للاحتياط بها فضلاً عن القول بدخولها في الزيارة.
وقد ذكر المحقّق القمّي : «أن الأظهر كون المدار وفاقاً لما ذكره الكفعمي على الإيماء بالسلام المختصر والصلاة ركعتين والزيارة المشهورة بتمامها والصلاة ركعتين أيضاً ودعاء الوداع ، وذكر أن الأوْلى تقديم الزيارة السادسة لأمير المؤمنين عليه السلام بصلواتها الستّ على زيارة عاشوراء على الكيفية المذكورة بملاحظة فعل صفوان المحكي عن أبي عبد الله عليه السلام.
وأنت خبير بأن الكفعمي ذكر الاجتهاد في اللعن على قاتل سيّد الشهداء عليه السلام بعد السلام المختصر ، وذكر أيضاً التكبير مائة مرة قبل الزيارة المشهورة(١) ، وكلام المحقّق(٢) المشار إليه خال عنهما كما ترى ، مع أن ظاهر كلامه قضية التعبير بالأظهر أن ما ذكره من باب بيان كيفية الزيارة واقعاً ، فمقتضاه مداخلة كل من الصلاتين معاً في الزيارة مع وضوح عدم مداخلة إحداهما ، أمّا الاُولى أو الثانية بلا شبهة. نعم ، الاحتياط يقتضي الإتيان بهما معاً ، مضافاً إلى أن ما ذكره من أولوية تقديم الزيارة السادسة يظهر ما فيه بما يأتي.
وبعد ما مرّ أقول :إنّ الكفعمي(٣) قد اعتبر بين الصلاة والتكبير أن يندب الزائر على سيّد الشهداء روحي وروح العالمين له الفداء ، ويبكي عليه ، ويأمر من في داره بذلك ممّن لا يتقيه ، ويقيم في داره مع من حضره المصيبة بإظهار الجزع عليه ، وأن يعزي بعضهم بعضاً بالمصاب بالحسين عليه السلام فيقولون : أعظم الله أجورنا وأجوركم
__________________
(١) تقدّمت الإشارة إليه عن المصباح: ٥٦٤
(٢) المراد به المحقّق القمّي ، الذي تقدّم آنفاً نقل كلامه.
(٣) تقدّمت الإشارة إليه في نقل كلامه من المصباح: ٥٦٤.
بمصابنا بالحسين عليه السلام ، وجعلنا وإيّاكم من الطالبين بثأره مع وليّه الإمام المهدي من آل محمّد عليهم السلام ، ومقتضاه إناطة ترتّب الثواب على الزيارة ، بل مقتضاه بلا كلام إناطة صدق الزيارة بما ذكر ، وهو(١) مأخوذ من رواية مالك برواية «كامل الزيارة» ، ورواية عقبة برواية «المصباح» ، لكن لم يذكر المحقّق القمّي فيما نسب إليه ووافقه اعتبار ما ذكر ، إلّا أنّه لم يذكر أيضاً فيما نسب إليه ووافقه الاجتهاد في اللعن والتكبير مائة مرّة أيضاً كما مر ، فيمكن أن يكون إسقاط ما ذكر من باب الغفلة لا من باب استفادة عدم القول باعتبار ما ذكر من الكفعمي.
أقول : إن سؤال مالك وعقبة(٢) يحتمل فيه أن يكون غرضه عن الزيارة في يوم عاشوراء ، وأن يكون عن عمل يوم عاشوراء ، والأوّل(٣) أظهر بلا إشكال لكونه بعد بيان ثواب زيارة عاشوراء ، لكن الثاني يناسب عدم دخول الندبة وأخواتها في الزيارة.
وعلى الأوّل يمكن أن يكون قول أبي جعفر عليه السلام : «إذا كان كذلك برز إلى الصحراء ...» إلى قوله : «ثمّ ليندب الحسين عليه السلام» ، بيان للزيارة ، وقوله عليه السلام : «ثمّ ليندب الحسين عليه السلام » من باب إفادة فائدة زائدة ، وعلى هذا لابد أن يكون قوله : «وأنا الضامن » ، عود إلى حال الزيارة ، فقوله عليه السلام : «ثمّ ليندب » ، في الحقيقة جملة معترضة في البين ، ويمكن أن يكون قوله عليه السلام : «ثمّ ليندب الحسين عليه السلام » من باب تتمّة شرح الزيارة ، وعلى هذا قوله عليه السلام : «وأنا الضامن » متعلّق بتمام ما تقدّم عليه ومنه الندبة وأخواتها ، لكن الثاني أظهر لتلائم أجزاء الكلام على الثاني بخلاف الأوّل
__________________
(١) ما ذكره الكفعمي في مصباحه.
(٢) مالك في رواية كامل الزيارة ، وعقبة في رواية المصباح.
(٣) مراده بالأوّل: الاحتمال الأوّل ، وهو كون السؤال عن الزيارة في يوم عاشوراء ، حيث كان الاحتمال الثاني هو كون السؤال عن عمل يوم عاشوراء.
للزوم كون قوله : «ثمّ ليندب» من باب الجملة المعترضة وهو خلاف الظاهر ، مع أنّه على الثاني يكون السؤال عن كيفية التعزية مربوطة ببيان الضمان والسؤال عن الضمان والجواب عنه ، وأما على الأوّل يكون السؤال المذكور أعني السؤال عن كيفية التعزية غير مربوطة بما ذكر وإنّما يكون مربوطة بالجمل المعترضة وهو خلاف الظاهر.
فعلى الأوّل يلزم عدم ارتباط قوله عليه السلام «ثمّ ليندب الحسين عليه السلام» بسابقه وكذا عدم ارتباط قوله : «وأنا الضامن » ، إذ على الأوّل لا يكون مربوطاً بسابقه المتصل به ، بل يكون مربوطاً بالسابق المنفصل ، وكذا عدم ارتباط السؤال عن كيفية التعزية بسابقه.
لكن نقول : إن الأوّل مقتضى فهم المشهور ، حيث إنه لم أظفر بمن جرى غير الكفعمي على اعتبار الندبة وأخواتها في مفهوم الزيارة أو على اعتبارها في تطرّق الثواب ، مضافاً إلى اعتضاد الأوّل بخلو رواية علقمة وفعل صفوان عن الندبة وأخواتها ، وإن أمكن القدح في دلالة فعل صفوان : بأن الظاهر أنه لم يكن في يوم عاشوراء ، فلا يتأتّى الاعتضاد.
وربما احتمل : أن يكون قوله : «وأنا الضامن لهم إذا فعلوا ذلك » متعلقاً بإقامة العزاء والتلاقي بالبكاء وتعزية البعض بعضاً ، فاسم الإشارة إشارة إلى القريب المتصل بملاحظة موافقة الضمير في [قوله]: «فعلوا» مع الضمير في [قوله]: «يتلاقون» في الجمعية وانفراد الضمائر السابقة على الضمير في «يتلاقون» ، وكذا السؤال عن كيفية التعزية بعد ذلك.
وهو مردود : بأن الثواب المشار إليه في قوله : «جميع هذا الثواب» هو الثواب المعهود المتقدم على الزيارة ، فلا مجال لكون الضمان على إقامة العزاء ، مع أن جمعية الضمير في [قوله]: «يتلاقون» إنّما هو في رواية «كامل الزيارة» ، وأمّا رواية
«المصباح» ففيها : «وليعزّ بعضهم بعضاً » وهو خال عن «يتلاقون» ، وأما السؤال عن كيفية العزاء فهو يرشد إلى مداخلة إقامة العزاء في المضمون عليه ولو بدخولها في الزيارة ، ولا يرشد إلى كون المضمون عليه خصوص إقامة العزاء(١) .
__________________
(١) وينبغي أن يعلم أنّ المتعارف في الزيارة من البعيد الجهر ، لكن تعيّن الجهر في حقّه خالٍ عن الوجه. اللّهمّ إلّا أن يقال بانصراف أخبار الزيارة إلى الجهر ، لكنّه لا يتمّ بناء على عموم أخبار الزيارة للقريب لو تعيّن الإخفات في حقّ القريب. منه رحمه الله.
تنبيهات
[التنبيه] الأوّل :
فيما ذكره العلّامة المجلسي قدِّس سرُّه في الاحتياط في زيارة عاشوراء
إن العلّامة المجلسي قدِّس سرُّه قد حكم فيما تقدّم من كلامه في «البحار» بأنه لعلّ الأحوط فعل الصلاة في المواضع المحتملة(١) ، وشَرَحَ في «تحفة الزائر» و «زاد المعاد» حال هذا الإجمال وبين مواضع الاحتمال ، قال : «مؤلف ﮔﻮيد كه : ﭼﻮن عبارة حديث تشويش عظيمي دارد وقابل احتمال بسيار هست اﮔﺮ اوّل زياره : السلام عليك يا أبا عبد الله تا وآل نبيّك بخواند ونماز زيارت را بكند وباز همان زيارت را اعاده كند بهتر است واﮔﺮ بعداز صد مرتبة لعنت بار دﻳﮕﺮ نماز بكند وبعد از صد مرتبة سلام بار دﻳﮕﺮ نماز بكند ومتصل بسجدة ، وبعد از سجده نيز نماز بكند شايد بجميع احتمالات عمل كرده باشد واﮔﺮ أول يكي از زيارات بعيده را بعمل آورد ونماز بكند وبعد از اين اعمال را بجا آورد ظاهراً كافي باشد»(٢) .
__________________
(١) تقدّم هذا الكلام في نقل كلام المجلسي ، وهو في بحار الأنوار: ٩٨: ٣٠١.
(٢) ترجمة العبارة الفارسيّة المذكورة في المتن: يقول المؤلّف: «لمّا كانت عبارة الحديث مرتبكة وفيها تشويش كبير ، وتحتمل احتمالات كثيرة ، فلو تقرأ الزيارة أوّلاً من:السَّلامُ عَلَيْكَ يا أبا عَبْدِاللهِ حتّى: وَآلَ نَبِيِّكَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ ، ثمّ تؤدّي ركعتي الزيارة ، ثمّ تعيد هذه الزيارة نفسها مرّة اُخرى ، فذلك أفضل ، ولو تصلّي مرّة اُخرى بعد اللعن مائة مرّة ، وكذلك بعد السلام مائة مرّة ، ثمّ توصلها بالسجدة ، ثمّ تصلّي بعد السجدة كذلك ، فلعلّك تكون»
الإيراد على كلام المجلسي قدِّس سرُّه
ويرد عليه :
أوّلاً : إنّه لم يأت بالإتيان بالزيارة قبل الصلاة وبعدها ، وهو الوجه الأوّل من الوجوه المذكوره في «البحار» ، فضلاً عمّا ذكرناه من الوجوه ، فمن أين يتأتى الإتيان بجميع الاحتمالات بما ذكره.
وثانياً : إنّ ما ذكره أخيراً هو الوجه الثاني من الوجوه المذكورة في «البحار» ، فكان عليه ذكره في أجزاء الاحتياط والإتيان بجميع الاحتمالات ، أعني قبل قوله : «شايد بجميع احتمالات عمل ﮔﺮده باشد»(١) .
نعم ، لمّا كان هذا الوجه مطابقاً لظاهر الرواية كان إظهار كفايته ثانياً مناسباً.
وثالثاً : إنّ قوله : «وباز همان زيارت را اعاده كند بهتر است»(٢) ، وكان المناسب أن يقول : «وبعد از اين اين اعمال را بعمل آورد»(٣) ، كما ذكره في الوجه الأخير إذ الإقتصار على تكرار السلام الطويل أعني القطعة الأولى من الزيارة لا مجال له.
وإن قلت : إن مراده أوّل أقسام التجزئة ، أعني ثالث الأقسام المذكورة في «البحار».
قلت : إن على هذا كان المناسب ذكر الإتيان باللعن وما بعده ، فقد ظهر بما ذكرناه هنا وفي الوجه الأوّل أنه قد أسقط من الوجوه المذكورة في «البحار» أوّلها وثالثها ،
__________________
«قد عملت بالاحتمالات كلّها ، ولو اُتي أوّلاً بواحدة من هذه الزيارات (الزيارات عن بُعد) وصلّى ثمّ ائتي بهذه الأعمال ، فالظاهر أنّها تكفي».
(١) ترجمة: «فلعلّك تكون قد عملت بالاحتمالات كلّها».
(٢) ترجمة: «ثمّ تعيد هذه الزيارة نفسها مرّة اُخرى ، فذلك أفضل».
(٣) ترجمة: «وبعد هذا يأتي بهذه الأعمال».
فمن أين يتأتّى الإتيان بجميع الاحتمالات.
ورابعاً : إنّ وجوه التجزئة خلاف الظاهر ، بل غير قابل للاحتمال ، فلا وقع للإتيان بها تحصيلاً للاحتياط.
وخامساً : إن قوله : «بهتر است»(١) ، غير مناسب إذ لم يظهر المفضل عليه ، فلا يتّجه التفضيل.
إلّا أن يقال : إن الغرض التفضيل بالنسبة إلى ما يقتضيه ظاهر الرواية.
لكن يظهر بما سمعت ما في تفصيل الصورة المذكورة ، فكان المناسب أن يذكر أوّلاً كفاية ما ذكره أخيراً ويذكر أن الإتيان بالزيارة قبل الصلاة وبعدها أولى ويذكر أن الاحتياط في الإتيان بهذين الوجهين مع الوجوه الأربعة المتطرقة على التجزئة.
وسادساً : إن قوله : «ومتصل بسجدة»(٢) ، غير مناسب أيضاً ، وكان المناسب أن يقول ، «وقبل از سجده»(٣) .
نعم ، الغرض الاتصال من جانب السبق إن عم الإتصال للسبق واللحوق وهو نظير ما ذكره من استحباب كون الغسل في ليال القدر مقارناً للغروب بناءً على كون الغرض المقارنة من جانب اللحوق ، وهو قد عبر بالإتصال بالسجدة أيضاً فيما تقدم من كلامه في «البحار».
وسابعاً : إن الاحتياط بإتيان الصلاة بعد السجدة كما ذكره في قوله : «وبعد از سجده»(٤) ، مبني على الاحتمال الشايع الذي جعله في «البحار» بعيداً جداً ،
__________________
(١) ترجمة: «أفضل».
(٢) ترجمة: «ثمّ توصلها بالسجدة».
(٣) ترجمة: «وقبل السجود».
(٤) ترجمة: «وبعد السجود».
وذكرنا أنه لا مجال له ، فإدراجه في أجزاء الاحتياط ليس بشيء.
وثامناً : إن الاحتياط بإتيان الصلاة بعد السلام المكرر ، لعلّه في حكم الصلاة بعد السجدة ، بناء على خروج الدعاء بالتخصيص عن الزيارة ، كما لعلّه الظاهر ويأتي.
وتاسعاً : إن استظهار كفاية الإيماء بالسلام بإحدى الزيارات البعيدة في الصورة الأخيرة كما ترى لعدم اختصاص الزيارة بالبعيد كما يظهر مما يأتي ولو كان الزيارة من القريب فكون الإيماء بالسلام بالزيارة البعيدة غير مناسب ، والظاهر أنه زعم اختصاص الزيارة بالبعيد ، كما هو مقتضى صدر رواية كامل الزيارة وصدر رواية «المصباح» وآخر رواية علقمة كما يأتي ويمكن أن يكون الاستظهار المذكور من العلّامة المشار إليه في زاد المعاد مبنياً على اختصاص الكتاب بالتعرض لزيارة البعيد كما يرشد إليه قوله في الباب الحادي عشر بعد الفراغ عن الزيارة الجامعة الكبيرة «مؤلف ﮔويد إين كامل ترين زياراتست از براي دور ونزديك وﭼون منظور عمده در اين رسالة زيارات بعيد است زيارت وداع را ذكر نكرديم»(١) ، ولكن نقول : إنه لو كان الأمر مبنياً على حسبان اختصاص الزيارة بالبعيد أو على اختصاص الكتاب بزيارة البعيد لكان كفاية الزيارة البعيدة بلا إشكال ولا يناسب الاستظهار والمظهر عن احتمال عدم الكفاية ، فكان المناسب استظهار كفاية الإيماء بالسلام المختصر.
وعاشراً : إن التعبير بالكفاية في استظهار كفاية كون الإيماء بالسلام بإحدى الزيارات البعيدة ظاهر في كون إحدى الزيارات البعيدة أقل ما يكفي ، مع أن أقل ما يكفي هو السلام المختصر ، فكان المناسب أيضاً استظهار كفاية الإيماء بالسلام المختصر من جهة التعبير بالكفاية ، مضافاً إلى جهة اعتبار الزيارة البعيدة لعدم(٢)
__________________
(١) ترجمة العبارة الفارسيّة المذكورة في المتن: يقول المؤلّف: «هذه أكمل زيارة عن قرب وبعد ، وبما أنّ الغرض من هذا الكتاب هو ذكر الزيارات عن بعد فلم أذكر الوداع».
(٢) تعليل لقوله: «مضافاً». منه رَحمَه اللهُ.
مناسبة اعتبار الزيارة البعيدة في المقام ، كما سمعت لعدم(١) مناسبة التعبير بالكفاية ، وقد ظهر بما تقدم أنه لم يأت بالوجه الأوّل والثالث من الوجوه المذكورة في «البحار» وأتى بالوجه الذي حكم ببعده جداً في «البحار» مع اختلال بعض كلماته في المقام.
وإن شئت كما التوضيح أقول : إنه كان المناسب في الوفاء بأداء المقصود أن يقول : «مؤلف ﮔويد عبارت حديث تشويش عظيمي دارد قابل احتمال بسيار هست اﮔﺮ اوّل يكي از زيارات بعيدة را بجا آورد ونماز بكند بعد از آن اين اعمال را بجا آورد ظاهراً كافي باشد واﮔﺮ اين أعمال را قبل از نماز وبعد از نماز بعمل آورد بهتر است واﮔﺮ هر دو صورت مذكور را معمول دارد وهم ﭼﻨﻴﻦ السلام عليك يا أبا عبد الله تا وآل نبيك بخواند ونماز زيارة را بكند وبقية أعمال را بعمل آورد وهم ﭼﻨﻴﻦ نماز را بعد از صد مرتبه لعن وبعد از صد مرتبة سلام وهم ﭼﻨﻴﻦ قبل از سجده متصلة بها شايد بجميع احتمالات عملكرده باشد»(٢) ، وبهذا ظهر لك شرح ما تقدم من كلامه في «البحار».
ومن باب مزيد التوضيح في شرح كلامه المذكور أقول : إن الاحتياط على حسب ما ذكره من الاحتمالات بالإتيان بالزيارة بتمامها قبل الصلاة وبعدها والإتيان بالسلام بأي نحو كان والصلاة والزيارة بتمامها والإتيان بالسلام الطويل ، أي الجزء الأوّل
__________________
(١) تعليل لقوله: «وكان المناسب». منه رَحمَه اللهُ.
(٢) ترجمة العبارة الفارسيّة المذكورة في المتن: يقول المؤلّف: «لمّا كانت عبارة الحديث مرتبكة وفيها تشويش كبير ، وتحتمل احتمالات كثيرة ، فلو تقرأ إحدى الزيارات (الزيارة عن بُعد) ، ثمّ تصلّي ركعتي الزيارة ، ثمّ تأتي بهذه الأعمال ، فالظاهر أنّها تكفي ، ولو تأتي بهذه الأعمال قبل الصلاة وبعدها فهو أفضل ، ولو تعمل بكلتا الصورتين ، وكذلك تقرأ السلام وتصلّي بعد اللعن مائة مرّة ، وبعد السلام مائة مرّة ، وكذلك قبل السجدة المتّصلة بها ، فقد عملت بالاحتمالات كلّها.
من الزيارة والصلاة واللعن والسلام المكررين والدعاء بالتخصيص والسجدة ، والإتيان بالسلام واللعن المكررين والصلاة والسلام المكررين والدعاء بالتخصيص والسجدة ، والإتيان بالسلام واللعن المكررين والصلاة والسلام المكررين والدعاء بالتخصيص والسجدة ، فقد بان أن الصلاة المتكررة من باب الاحتياط اثني عشر صلاة.
وأما ما ذكره العلّامة المجلسي قدس سره في «تحفة الزائر» و «زاد المعاد» فهي ترجع إلى عشر صلوات ، لكن ركعتان من العشرة في الصورة الأولى مما ذكره من الصور ليست من باب تكرار الزيارة ولا تدخل في صور التجزية وركعتان منها في الصورة الأخيرة مما ذكره من الصور وقد سمعت أن هذه الصورة لا مجال لها ، وحكم ببعده جداً في «البحار».
والعلّامة المشار إليه في الكتابين(١) قد اسقط ركعتين من الصورة المتروكة وهي صورة الإتيان بالزيارة قبل الصلاة وبعدها.
وبعد ذلك أقول : إنه كان المناسب تصوير الاحتياط بما يشتمل على ما يقتضيه رواية «المصباح» ولا جدوى في تصوير الاحتياط بما يشتمل على وجوه الاحتمال المتصورة في رواية كامل الزيارة فالاحتياط يقتضي اعتبار التكبير قبل الزيارة حسب ما يقتضيه ذيل رواية «المصباح» ويكفي في التكبير الإتيان به مرة واحدة ، ولكن اعتبر بعض الأعلام الإتيان به مرات متعددة بل جرى الكفعمي على الإتيان به مائة مرة ، فالأحوط الإتيان بالمائة.
__________________
(١) مرادة العلّامة المجلسي ، وفي الكتابين: زاد المعاد ، وتحفة الزائر.
تحقيق الكلام في الاحتياط في المقام
وتحقيق الكلام في الاحتياط في المقام : أنه لابد في تشخيص الأحوط والأخذ بالاحتياط من تصوير الاحتياط في العمل برواية كامل الزيارة وكذا تصوير الاحتياط في العمل برواية «المصباح» ثم تصوير الجمع بين الإحتياطين.
فلابد من نشر الكلام في مقامات ثلاثة :
[المقام] الأوّل : في الاحتياط في العمل برواية كامل الزيارة
فنقول : إن رواية كامل الزيارة يدور الأمر فيها بين ثبوت الواو العاطفة قبل ، بعد ، وسقوطها ، وعلى الأوّل إما أن يكون قوله عليه السلام : «وقلت» معطوفاً على قوله : «صليت» ، أو قوله عليه السلام : «تومئ» ، إما على تقدير ثبوت الواو وكون قوله : «وقلت» معطوفاً على قوله : «صليت» فإما أن يتّحد الإيماء أو يتعدد.
وعلى الأوّل المدار على الزيارة والصلاة والزيارة ، وعلى الثاني المدار على السلام والصلاة والزيارة والصلاة والزيارة ، وعلى التقديرين وأن يتأتّى احتمال التجزية بأقسامها ، لكنه خلاف ظاهر بل خلاف المقطوع به فلا حاجة إلى تحرير الحال بناء على ذلك الاحتمال.
وأما على تقدير ثبوت الواو وكون قوله : «فقلت» ، معطوفاً على قوله عليه السلام : «تومئ » ، فلابد من تعدد الركعتين وإلّا يلزم كون الركعتين بعد الركعتين بتوسط الزيارة على تقدير اتحاد الإيماء وبتوسط السلام والزيارة على تقدير تعدد الإيماء ، وعلى تقدير تعدد الركعتين إما أن يتحد الإيماء أو يتعدد.
وعلى الأوّل لابدّ في إحراز مصداق الرواية من الصلاة أخيراً بعد أمرين ـ أعني الصلاة والزيارة ـ ولا خفاء في إمكان تقدم كل منهما على الآخر ، فالمدار على الصلاة والزيارة والصلاة ، والمدار على الزيارة والصلاة والصلاة.
وعلى الثاني لابد في إحراز مصداق الرواية من الصلاة أخيراً بعد أمور ثلاثة ـ أعني السلام والزيارة والصلاة ـ ولا خفاء في إمكان تقدم كل من الأمور الثلاثة على أخويه ، وكذا تقدم كل من الأخوين على الآخر.
فالمدار على السلام والزيارة والصلاة والصلاة على تقدير تقدم السلام على أخويه مع تقدم الزيارة على الصلاة.
والمدار على السلام والصلاة والزيارة والصلاة على التقدير المذكور مع تقدم الصلاة على الزيارة.
والمدار على الزيارة والسلام والصلاة والصلاة على تقدير تقدم الزيارة على أخويه مع تقدم السلام على الصلاة.
والمدار على الزيارة والصلاة والسلام والصلاة على التقدير المذكور مع تقدم الصلاة على السلام.
والمدار على الصلاة والزيارة والسلام والصلاة على تقدير تقدم الصلاة على أخويه مع تقدم الزيارة على السلام.
والمدار على الصلاة والسلام والزيارة والصلاة على التقدير المذكور مع تقدم الصلاة على الزيارة ، وأما على تقدير سقوط الواو فإما أن يكون قوله عليه السلام : «وقلت» ، معطوفاً على قوله : «صليت» ، أو يكون معطوفاً على قوله عليه السلام : «تؤمى»
وعلى الأوّل لابد من تعدد الإيماء وإلا يلزم أن يكون الركعتان بعد الركعتين بتوسط الزيارة ، وعلى تقدير التعدد إما أن يتحد الركعتان أو يتعددان ، وعلى الأوّل المدار على السلام والصلاة والزيارة ، وعلى الثاني المدار على السلام والصلاة والصلاة والزيارة. وعلى الثاني إما أن يتحد الإيماء(١) أو يتعدد.
__________________
(١) قوله: «وعلى الثاني: إمّا أن يتّحد» أي على تقدير كون قوله عليه السلام: «وقلت » معطوفاً»
وعلى الأوّل لابد من تعدد الركعتين وإلّا يلزم تقدم الركعتين على الركعتين بتوسط الزيارة أيضاً ، فالمدار على الصلاة والزيارة والصلاة ، وعلى الثاني لابد في إحراز مصداق الرواية من الصلاة أخيراً بعد السلام وبعد الصلاة المتعقبة بالزيارة ، ولا خفاء في إمكان تقدم السلام على الصلاة وبالعكس ، وبعبارة أخرى إمكان تقدم المتحد على المتعدد وبالعكس ، فالمدار على السلام والصلاة والزيارة والصلاة على تقدير تقدم السلام والمدار على الصلاة والزيارة والسلام والصلاة على تقدير تقدم الصلاة ، وكيف كان فعلى تقدير ثبوت الواو وكون قوله : «وقلت» ، معطوفاً على قوله : «صليت» ، فالمدار على الزيارة والصلاة والزيارة على تقدير اتحاد الإيماء ، والمدار على السلام والصلاة والزيارة والصلاة والزيارة على تقدير تعدد الإيماء ، لكن الأوّل يدخل في الثاني ، فالاحتياط في الثاني ، وأما على تقدير ثبوت الواو وكون قوله : «وقلت» معطوفاً على قوله : «تومئ».
أما على تقدير اتحاد الإيماء فالظاهر بل بلا إشكال قضية الإطلاق كفاية الصلاة والزيارة والصلاة وكذا كفاية الزيارة والصلاة والصلاة ، لكن الاحتياط بزيادة الزيارة والصلاة على الوجه الثاني فالمدار على الزيارة والصلاة والصلاة والزيارة والصلاة.
وأما على تقدير تعدد الإيماء فالظاهر بل بلا إشكال كفاية أحد الوجوه المتقدّمة ، أعني كفاية السلام والزيارة والصلاة والصلاة ، وكذا كفاية السلام والصلاة والزيارة والصلاة ، وكذا كفاية الزيارة والسلام والصلاة والصلاة ، وكذا كفاية الصلاة والزيارة والسلام والصلاة ، وكذا كفاية الصلاة والسلام والزيارة والصلاة.
لكن الأوّل يندرج فيه الثاني بزيادة الزيارة بين الصلاتين بناء على عدم ممانعة تخلل الزيارة بين السلام والصلاة في الأوّل وعدم ممانعة تخلل الزيارة بين الصلاتين في الثاني وإلّا فالاحتياط بالسلام والزيارة والصلاة والصلاة والسلام والصلاة والزيارة
__________________
«على قوله عليه السلام: «تومئ». منه رحمه الله.
والصلاة ، والثالث يندرج فيه الرابع بزيادة السلام بين الصلاتين بناء على عدم ممانعة تخلل السلام بين الزيارة والصلاة في الثالث وعدم ممانعة تخلل السلام بين الصلاتين في الرابع ، وإلا فالاحتياط بالزيارة والسلام والصلاة والصلاة والزيارة والصلاة والسلام والصلاة ، والخامس يندرج فيه السادس بزيادة الزيارة بين السلام والصلاة بناء على عدم ممانعة تخلل الزيارة بين الصلاة والسلام في الخامس وتخلل الزيارة بين السلام والصلاة في السادس وإلا فالاحتياط بالصلاة والزيارة والسلام والصلاة والسلام والزيارة والصلاة.
أما على تقدير سقوط الواو فالوجوه المتقدّمة فيه أربعة ، رابعها دائر بين وجهين :
أحدهما : السلام والصلاة والزيارة.
ثانيهما : السلام والصلاة والصلاة والزيارة.
ثالثها : الصلاة والزيارة والصلاة.
رابعها : السلام والصلاة والزيارة والصلاة أو الصلاة والزيارة والسلام والصلاة ، أما الأوّل فهو يندرج في الثاني بناء على عدم ممانعة تخلل الصلاة بين الصلاة والزيارة وإلا فالاحتياط بمزيد الثاني على الأوّل ، فالمدار على السلام والصلاة والزيارة والسلام والصلاة والصلاة والزيارة ، أو بالعكس ، فالمدار على السلام والصلاة والصلاة والزيارة والسلام والصلاة والزيارة ، وأما الثالث فيندرج في الأوّل بمزيد الصلاة على الأوّل في آخر ، فالمدار على السلام والصلاة والزيارة والصلاة ولو زيد على الوجه الأوّل(١) من الوجهين الأولين المذكورين تخييراً في الجمع بين الوجهين
__________________
(١) قوله: «ولو زيد على الوجه الأوّل» ، ولا يذهب عليك أنّه لو زيد على الوجه المذكور الصلاة بحسب الزيارة الاُولى لجاء الاحتياط أيضاً بين الوجوه المشار إليها ، وهو أوْلى ، لكونه أخصر. غاية الأمر أنّه يلزم تأخير الوجه الثاني عن الثالث والرابع ، ولا بأس به لعدم قدحه في الاحتياط ، كما لا يخفى. منه رحمه الله.
الأولين من الوجوه المتقدّمة في باب سقوط الواو والسلام والصلاة والزيارة والصلاة ، وكذا السلام والصلاة لجاء الاحتياط بين الوجوه المتقدّمة في باب سقوط الواو ، وكان المدار على السلام والصلاة والزيارة والسلام والصلاة والصلاة والزيارة والسلام والصلاة والزيارة والصلاة والسلام والصلاة ، وأما الأخير فالأخير منه يندرج في الأوّل منه(١) بمزيد السلام على الأوّل فيما قبل الآخر ، فالمدار على السلام والصلاة والزيارة والسلام والصلاة.
وبالجملة فقد ظهر مما مر أن الاحتياط على تقدير ثبوت الواو وكون قوله عليه السلام : «وقلت » معطوفاً على قوله عليه السلام : «صلّيت » ، بالسلام والصلاة والزيارة والصلاة والزيارة ، وأما على تقدير ثبوت الواو وكون قوله عليه السلام : «وقلت » ، معطوفاً على قوله عليه السلام : «تومئ » ، أما على تقدير اتحاد الإيماء ، فالاحتياط بالزيارة والصلاة والصلاة والزيارة والزيارة والصلاة وأما على تقدير تعدد الإيماء ، فقد تقدم وجوه ثلاثة يحتاط بها بين كل من وجهين :
أحدهما : السلام والزيارة والصلاة والصلاة والسلام والصلاة والزيارة والصلاة.
ثانيهما : الزيارة والسلام والصلاة والصلاة والزيارة والصلاة والسلام والصلاة.
ثالثها : الصلاة والزيارة والسلام والصلاة والسلام والزيارة والصلاة.
وهذه الوجوه يكفي واحد منها لكفاية واحد منها من وصولها بحكم الإطلاق فضلاً عن الاحتياط بوجهين منها.
وأما على تقدير سقوط الواو ، فقد تقدم في الاحتياط فيه وجوه أربعة يحتاط بين الأولين منها على سبيل التخيير.
__________________
(١) قوله: «فالأخير منه يندرج في الأول منه» ، والأوّل منه يندرج في الأخير منه بمزيد السلام على الأخير في الأوّل ، ولا يختلف المدار. منه رحمه الله.
لكن نقتصر هنا على ذكر الأوّل من الأولين ، فالوجوه :
أحدها : السلام والصلاة والزيارة والسلام والصلاة والصلاة والزيارة.
ثانيها : الزيارة والسلام والصلاة والصلاة والزيارة والصلاة والسلام والصلاة.
ثالثها : الصلاة والزيارة والسلام والصلاة والسلام والزيارة والصلاة.
وفذلكة الوجوه : خمسة ولا يندرج شيء منها في شيء ، ولابد في الاحتياط بحيث لا يتخلل التخلل في البين من الجمع بين الخمسة ، وهو يتصور على مائة وعشرين صورة ، لكن لو أتى بالوجه الأوّل وهو ما يحتاط به على تقدير ثبوت الواو وكون قوله عليه السلام : «وقلت» معطوفاً على قوله عليه السلام : «صليت» مع انضمام الوجه الثاني ، وهو ما يحتاط به على تقدير اتحاد الإيماء على تقدير كون قوله عليه السلام : «وقلت» معطوفاً على قوله عليه السلام : «تومئ» ومع انضمام أحد من وجوه الاحتياط على تقدير ثبوت الواو وكون قوله عليه السلام : «وقلت» معطوفاً على قوله عليه السلام : «تومئ» مع تعدد الإيماء ومع انضمام ما تقدم الاحتياط به بين الوجوه الثلاثة المحتاط بها على تقدير سقوط الواو لكان كافياً.
فالمدار على السلام والصلاة(١) والزيارة والصلاة والصلاة والزيارة(٢) والصلاة
__________________
(١) قوله: «السلام والصلاة» هذا هو الوجه المحتاط به على تقدير ثبوت الواو ، وكون قوله عليه السلام : «وقلت » معطوفاً على قوله: «صلّيت ».
(٢) قوله: «والزيارة والصلاة ، والصلاة والزيارة» هذا هو الوجه المحتاط به على تقدير ثبوت الواو ، وكون قوله عليه السلام: «وقلت » معطوفاً على قوله: «تومئ » مع اتّحاد الإيماء ، لكنّه بإسقاط الزيارة والصلاة والزيارة آخر الوجه الأؤّل لكون التكرار لغواً ، ويمكن جعل الأمر بالعكس.
فالصلاة الواقعة عقيب الزيارة من الوجه الثاني ، وأسقط الصلاة واختارها من صدر الوجه الثاني ، ولا فرق في البين ولا ثمرة في ذلك. منه رحمه الله.
والسلام والزيارة والصلاة والصلاة(١) والسلام والصلاة(٢) والسلام والصلاة والصلاة والزيارة والسلام والصلاة والزيارة والصلاة والسلام والصلاة.
[المقام] الثاني : في الاحتياط في العمل برواية «المصباح»
فنقول : إن الأمر فيها دائر بين كون قوله : «فقل» جزاء للشرط وكونه معطوفاً على قوله : «تومئ» ، وعلى الأوّل المدار على السلام والصلاة والتكبير والزيارة ، وعلى الثاني المدار على السلام والتكبير والزيارة والصلاة.
والاحتياط إما أن يكون مع حفظ مرتبة الاتصال ، وإما أن يكون مع عدم حفظ هذه المرتبة.
وعلى الأوّل الاحتياط إما بالسلام والصلاة والتكبير والزيارة والسلام والتكبير والزيارة والصلاة ، أو بالسلام والتكبير والزيارة والصلاة والسلام والصلاة والتكبير والزيارة.
وعلى الثاني الاحتياط إما بالسلام والصلاة والتكبير والزيارة عملاً بالوجه الأوّل وزيادة الصلاة بعد الزيارة عملاً بالوجه الثاني ، إلّا أن التكبير في الوجه الثاني بعد السلام ، وهنا بعد الصلاة أو بالسلام والتكبير والزيارة والصلاة ، عملاً بالوجه الثاني وزيادة التكبير والزيارة بعد الصلاة عملاً بالوجه الثاني ، وزيادة التكبير والزيارة بعد الصلاة عملاً بالوجه الأوّل ، إلّا أن الصلاة في الوجه الأوّل بعد السلام بلا واسطة ، وهنا بتوسط التكبير والزيارة.
__________________
(١) قوله: «والسلام والزيارة ، والصلاة والصلاة» هذا هو أوّل الوجوه الثلاثة المحتاط بها على تقدير ثبوت الواو ، وكون قوله عليه السلام: «وقلت» معطوفاً على قوله: «تومئ» مع تعدّد الإيماء. منه رحمه الله.
(٢) قوله: «والسلام والصلاة» هذا هو الوجه المحتاط به من الوجوه الثلاثة المحتاط بها على تقدير سقوط الواو. منه رحمه الله.
[المقام] الثالث : في الجمع بين الاحتياط في العمل برواية كامل الزيارة والاحتياط في العمل برواية «المصباح»
فنقول : إن الأولى نشر الكلام بناء على حفظ مرتبة الإتصال في باب الاحتياط برواية «المصباح» مع الاحتياط في العمل برواية كامل الزيارة ، بحيث لا يتخلّل متخلّل في البين ، فالجمع بين الإحتياطين بزيادة السّلام والصّلاة والتكبير والزّيارة والسّلام والتكبير والزيارة والصلاة أو زيادة السّلام والتكبير والزيارة والصّلاة والتكبير والزيارة قبل الوجوه المجموعة في باب الاحتياط في العمل برواية كامل الزّيارة أو بعد تلك الوجوه أو قبل الوجوه المتوسّطة.
وربّما يتوهّم : كون الأحوط الإتمام بالسّلام قضيّة الإيماء بالرّكعتين في فعل صفوان
لكنّك خبيرٌ بأن الظاهر كون الإيماء من باب الوداع لا الزيارة كما مرّ.
وبعد هذا أقول : إنّ الظاهر خروج السجدة عن الزيارة ، إذ الظاهر خروجها عن القول المذكور في رواية كامل الزيارة ورواية «المصباح» كما مرّ ، بل لعل الظاهر خروج الدّعاء بالتخصيص عن الزيارة كما مرّ ، فلا حاجة إلى السّجدة في الزيارة الأولى ، بل لا حاجة إلى الدّعاء بالتخصيص أيضاً في الزيارة الأولى ، نعم لابدّ في الزّيارة الثانية إتماماً للعمل.
فيما ذكره الوالد الماجد قدس سره في الاحتياط
بقي أن الوالد الماجد قدس سره(١) قال في مقام بيان الاحتياط : «والظاهر أنه لو أومأ أولاً
__________________
(١) هو الشيخ الجليل ، والعالم النبيل ، محمّد إبراهيم الكلباسي الأصفهاني (١١٨٠ ـ ١٢٦١ هـ. ق) من أعاظم علماء عصره.
ولد في مدينة أصفهان ، وهاجر إلى العراق فأدرك الوحيد البهبهاني والسيّد مهدي»
وزاره بمثل السّلام عليك يا أبا عبد الله السّلام عليك ورحمة الله وبركاته ، ثمّ صلّى ركعتين صلاة الزيارة احتياطاً ، ثم كبّر مائة مرة ولو كان أقل لكفى بل ولو كان مرّة ، ثم أتى بالزيارة المشهورة ، ثم صلّى ركعتين بعد الفراغ من دعاء السجدة الّذي يكون في آخر الزيارة لكان حسناً».
ثمّ قال : «ولو احتاط بأن يصلّي ستّ ركعات اُخر بأن يُصلّى ركعتين بعد اللّعن مائة مرة وركعتين بعد التسليم مائة مرة وركعتين قبل السجدة لم يكن به بأس»(١) .
أقول : إنّ ما ذكره من طريق الاحتياط إنّما ينطبق على الاحتياط في العمل برواية «المصباح» بالعمل على طبق كون قوله عليه السلام : «فقل » معطوفاً على قوله عليه السلام : «تومئ » وإتمامه بالصّلاة احتياطاً كما لو كان قوله عليه السلام المذكور ، أعني قوله عليه السلام : «فقل » جزاءاً للشرط لا العكس ، وهو الإتيان بالسّلام والتكبير والزيارة والصّلاة والزيارة ،
__________________
«بحر العلوم والشيخ كاشف الغطاء والسيّد عليّ الطباطبائي صاحب الرياض والمقدّس الكاظمي ، وحضر عليهم مدّة طويلة ، ثمّ رجع إلى إيران فحلّ في بلدة قم ، واشتغل بها على المحقّق القمّي صاحب القوانين ، ثمّ سافر إلى كاشان فحضر فيها عند العالم الشهير المولى محمّد مهدي النراقي صاحب جامع السعادات ، ثمّ عاد إلى اصفهان فكان بها الزعيم الروحي والرئيس المطاع.
هذه الترجمة مقتطفة من مقدّمة الرسائل الرجاليّة ، ولا يخفى أنّ اسمه الشريف مركّب (محمّد إبراهيم) ، وبعضهم يسميّه إبراهيم ، فاسم ولده (مصنّف هذه الرسالة) محمّد بن محمّد إبراهيم الكلباسي ، وليس محمّد بن محمّد بن إبراهيم ، كما قد يقع فيه الاشتباه.
وقد ترجم له في روضات الجنّات ، وفي قصص العلماء ، وتكملة أمل الآمل ، وألّف حفيده الشيخ أبو الهدى نجل المصنّف كتاباً خاصّاً في ترجمة والده وجدّه أسماه (البدر التمام في ترجمة الوالد القمقام ، والجدّ العلّام) ، وترجم له في أعيان الشيعة ، وفي الكرام البررة.
(١) منهاج الهداية: ١٧١.
ولا الجمع بين مدلول الرواية على تقدير كون قوله : «فقل» معطوفاً على قوله : «تومئ» والمدلول على تقدير كون قوله : «فقل» جزاء للشرط بالسّلام والصلاة والتكبير والزيارة والسّلام والتكبير والزيارة والصّلاة تقديماً كما لو كان قوله : «فقل» معطوفاً على قوله : «تومئ» وتأخيراً كما لو كان قوله : «فقل» المذكور جزاء للشرط أو بالسّلام والتكبير والزيارة والصّلاة والسّلام والصلاة والتكبير والزّيارة تقديماً كما لو كان قوله : «فقل» معطوفاً على قوله : «يومئ» ، وما صنعه من الاحتياط من الإقتصار على ما يقتضيه الاحتياط في العمل برواية «المصباح» نظير اقتصار العلّامة المجلسي قدس سره في باب الاحتياط على ما يقتضيه رواية كامل الزيارة كما يظهر مما مرّ
وأنت خبير بأنه لا جدوى فيما ذكره أولاً في بيان الاحتياط لابتنائه على الاقتصار في الاحتياط على ما يقتضيه رواية «المصباح» ، كما أنه لا جدوى في الاقتصار علي ما يقتضيه الاحتياط في العمل برواية كامل الزيارة كما مرّ في الإيراد على العلّامة المجلسي قدس سره ، بل لابد في الاحتياط من الجمع بين مايقتضيه الاحتياط في العمل برواية كامل الزيارة وما يقتضيه الاحتياط في العمل برواية «المصباح».
ومع هذا أقول : إنّ ما ذكر ثانياً في بيان الاحتياط بالوجه الأوفى مبني على مراعاة وجوه التجزية واحتمال التجزية بأقسامها خلاف الظاهر ، بل مقطوع العدم كما مرّ ، فلاحاجة إلى مراعاتها بل مراعاتها من قبيل الوسواس.
ومع هذا أقول : إنّ ما ذكره ثانياً في بيان الاحتياط بالوجه الأوفى يكون صدره خالياً عما يحتاج إليه بناء على مراعاة احتمال التجزية وذيله حاوياً لما لايحتاج إليه ، أمّا الأوّل فلخلوه عن الركعتين قبل اللّعن ، وقد احتاط بهما العلّامة المجلسي قدس سره فيما تقدم من كلامه ، وإن كان الاحتياط على وجه غير مرضى كما يظهر مما مرّ ، وأما الثاني فلاشتماله على الركعتين بعد السجدة ، إذ لا مجال لاحتمال كون الركعتين بعد السجدة كما يظهر ممّا تقدّم من الإيراد على الاحتياط بالصّلاة بالركعتين بعد السجدة من العلّامة المجلسي قدس سره.
فيما ذكر شيخنا السيّد في الاحتياط(١)
وبما مر يظهر ضعف ما صنعه شيخنا السيّد ، حيث احتاط بأن أومأ وزار بمثل السّلام عليك يا أبا عبد الله السّلامُ عليك وَرحمة الله وبركاته ، ثم صلّى ركعتين ، بعد الفراغ من اللّعن مائة مرة وركعتين بعد التسليم كذلك وركعتين قبل السجدة وركعتين بعد السجدة ، قال : فهذه عشر ركعات يأتي بكلها للزيارة بقصد القربة المطلقة والأهم من هذه الركعات الجنبان».
والظاهر أنه(٢) مبني على الجمع من الاحتياطين المذكورين في كلام الوالد الماجد قدس سره كما سمعت.
فيما ذكره بعض في الاحتياط(٣)
وربما احتاط بعض بأن زار بالزيارة السادسة لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام وإن كانت الزيارة المشهورة أولى ثم صلّى ركعتين ثم كبّر مائة مرّة ثم زار بالزيارة المشهورة مع السجدة ثم صلّى ركعتين.
أقول : إنّ ما ذكره(٤) من الاحتياط بالإبتداء بالزيارة السادسة مأخوذ من كلام العلّامة المجلسي قدس سره في تحفة الزائر وزاد المعاد في باب زيارات أمير المؤمنين عليه السلام بعد الزيارة السادسة ، بل هو مقتضى ما مضى من المحقّق القمّي ، ويأتي وضوح فساده.
وبعد هذا أقول : إنه إن كان المقصود بالاحتياط المذكور هو الوجه الوافي بجميع الوجوه المخالفة للظاهر ، فزيادة الصلاة في الآخر لا توجب الوفاء بجميع تلك
__________________
(١) و (٣) لم نعثر عليه.
(٢) ما ذكره السيّد.
(٤) هذا البعض.
الوجوه ، وإن كان المقصود الوجه الوافي بالوجوه الظاهرة ، فلا حاجة إلى الصلاة بالآخرة كما يظهر ممّا ذكرناه عند الكلام في الاحتياط في الوجوه الظاهرة.
فيما جرى عليه بعض أصحابنا في الاحتياط
وقد جرى بعض أصحابنا على أنّ المدار على الزيارة المشهورة بين الصلاتين ، ومقتضى كلامه أنّ الأولى الابتداء بزيارة أمير المؤمنين عليه السلام مع صلاتها ، والظاهر بل بلا إشكال أن ما جرى عليه من باب الاحتياط لا بيان الكيفية الواقعية ، لوضوح عدم مداخلة الصّلاتين معاً في الزيارة.
لكن نقول : إنّ ما جرى عليه من الاحتياط بزيارة أمير المؤمنين عليه السلام مع صلاتها يظهر وضوح فساده بما يأتي ، مضافاً إلى أنه لا يتم إلّا بناء على اشتمال زيارة أمير المؤمنين عليه السلام مطلقاً على الصّلاة ، وليس الأمر كذلك لخلو بعض زياراته عليه السلام عن الصلاة.
ومع هذا نقول : إنّ الاحتياط يقتضي الإيماء بالسّلام المختصر ابتداء كما يظهر ممّآ مرّ ، كما أنّ الاحتياط يقتضي الإتيان بالتكبير ولو مرّه قبل الزيارة ، وما ذكره خال عن السّلام والتكبير.
[التنبيه] الثاني :
[فيما ذكره السيّد الداماد (١) من التفصيل بين القريب والبعيد في تقديم الزيارة ، سواء كانت زيارة عاشوراء أو غيرها ، على الصلاة وتقديم الصلاة على الزيارة]
إنّ السيّد الداماد قد فصّل نقلاً في الرسالة التي عملها في الآداب وأدعية الأيام الأربعة : يوم دحو الأرض ، ويوم غدير ، ويوم المولود ، ويوم المبعث(٢) ، بتأخّر صلاة الزيارة في زيارة عاشوراء وغيرها من الزيارات عن الزيارة للقريب وتقدمها عليه للبعيد(٣) ، بل حكاه عن ابن زهرة(٤) والشيخ الطوسي في «المصباح» والشهيد في «الذكرى»(٥) ، قال(٦) بالفارسية :
«مسئله آﻧﭽﻪ ذكر كرديم كه زيارت هرﮔﺎه از دور باشد وتحت قبه هيـﭻ معصومي نباشد نماز زيارت مقدّم است حكميست مطرد در زيارت رسول الله صلى الله عيه وآله وزيارت امير المؤمنين عليه السلام وزيارت هر يك از معصومين صلوات الله عليهم أجمعين ، واين مسئله
__________________
(١) مرّت ترجمته في الصفحة ٤٠.
(٢) وهي المسمّاة بـ (الأربعة الأيّام).
(٣) وقد ذكر بعض أصحابنا: أنّ الصلاة في الزيارة البعيدة مقدّمة على الزيارة على الأظهر ، لكنّ الأوْلى إعادتها بعد الزيارة. منه رحمه الله.
(٤) في غنية النزوع ، كما ستأتي الإشارة لذلك.
(٥) أي حكى السيّد الداماد هذا التفصيل عن السيّد ابن زهرة ، وحكاه عن الشيخ في المصباح ، وحكاه عن الشهيد في الذكرى.
(٦) أي السيّد الداماد في رسالته المذكورة.
از خفاياى مسائل وخفيات احكام است ، تا كس كمال مهارت وتمام بضاعت در فقه وحديث نداشته باشد بر اين دقه اطلاعى نمى يابد واز اين جهة اكثر اهل روزﮔﺎر از حكم اين نوع غافلند از اين زمان سيوشش سال كه داعى دولت قاهره از تصنيف كتاب صراط المستقيم فارغ شده بود در دار السّلطنة قزوين ﭘﺎدشاه جمجاه مغفور مرحوم شاه عباس را در يكى از ايام اربعه در ﭘﺸﺖ مسجد ﭘﻨﺠﻪ علي تعليم وتلقين زيارت ميكرديم بطريق مذكور بعضى از معاصرين كه كمال شهرة داشت معارض شده از روى تعجب كفت نماز قبل از زيارت ﭼﻪ صورت دارد ميبايد كه بعد از زيارت بوده باشد فقير در جواب ﮔﻔﺖ : شما را اشتباهى واقع شده است اﮔﺮ از نزديك باشد نماز مؤخر ميباشد واﮔﺮ از دور باشد زيارت مؤخر است از نماز مجادله ومناظره بطول انجاميد آخر الامر كتابها حاضر ساخته بعبارت صريحه الزام واسكات معاصر مناظر حاصل شده ، ﭼﻮن اين مسئله غريب ودقيق است عبارت بعضى از أعاظم اصحاب رضى الله تعالى عنهم ذكر ميكنم تا متعلمين از باب وليطمئن قلبى وسوسه در خاطر نماند.
سيّد فقيه مكرم ابن زهره الحلبى ومن اسم او را در كتاب «ضوابط الرضاع» تحقيق كردەام در كتاب غيبة النزوع باين عبارت ﮔﻔﺘﻪ است : «وأما صلاة الزيارة للنبيّ صلى الله عليه وآله أو لأحد من الأئمّة عليهم السلام فركعتان عند الرأس بعد الفراغ عن الزيارة ، فإن أراد الإنسان الزيارة لأحدهم وهو مقيم في بلده قدم الصلاة ثم زار عقيبها»
وشيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي نوّر الله تعالى مرقده در كتاب «مصباح متهجّد» در باب فضل يوم الجمعه فرموده : «روى عن الصادق عليه السلام أنه قال :من أراد يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وقبر أمير المؤمنين عليه السلام وفاطمة والحسن والحسين وقبور الحجج عليهم السلام فليغتسل في يوم الجمعة ، ويلبس ثوبين نظيفين ، وليخرج إلى فلاة (١) من الأرض ،
__________________
(١) الفلاة: أرض لا ماء فيها ، والجمع: فلا مثل: حصاة وحصاه ، وجمع الجمع: أفلاء مثل:»
ثمّ يصلّي أربع ركعات يقرأ فيها ما تيسّر من القرآن، فإذا تشهّد وسلّم فليقم مستقبل القبلة وليقل : السّلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته إلى آخر الزيارة.
وفي رواية أخرى : «افعل ذلك على سطح» ، ويستحب زيارة أبي عبد الله الحسين بن عليّ عليهما السلام مثل ذلك بعد أن يغتسل ويعلو سطح داره أو في مفازة من الأرض وتومي إليه بالسّلام ويقول : السّلام عليك يا مولاي وسيّدي الخ.
ودر زيارة عاشوراء از دور نيز در رواية علقمة بن محمّد الحضرمي از مولاى ما أبي جعفر الباقر عليه السلام تقديم الصلاة وتأخير الزيارة در «مصباح» مذكور است ، وعروة الوثقى أبو جعفر بن بابويه رضوان الله تعالى عليه در كتاب «من لا يحضره الفقيه» ذكر كرده باب ما يقوم مقام زيارة الحسين وزيارة غيره من الأئمّة عليهم السلام لمن لا يقدر على قصده لبعد المسافة.
روى ابن ابي عمير عن هشام ، قال : «قال أبو عبد الله عليه السلام :إذا بعدت لأحدكم الشقة ، ونأت به الدار ، فليصعد أعلى منزله ، وليصلّ ركعتين ، وليومِ بالسّلام إلى قبورنا ، فإنّ ذلك يصل إلينا.
وشيخنا الشهيد محمّد بن مكّي قدّس الله نفسه القدسية در كتاب ذكرى نماز زيارت را از نزديك قبر رسول صلى الله عليه وآله يا أمير المؤمنين يا يكي از ائمّة معصومين سلام الله عليهم اجمعين ذكر كرده است ﮔﻔﺘﻪ است : وهي ركعتان بعد الفراغ من الزيارة تصلّي عند الرأس بعد أز آن ﮔﻔﺘﻪ است».
قال ابن زهرة رحمة الله تعالى : «من زار وهو مقيم في بلده قدّم الصلاة ثمّ زار عقيبها»(١) .
__________________
«سبب وأسباب ، ذكره في المصباح. منه رحمه الله.
(١) غنية النزوع: ١٠٩.
وقد حكى القاشاني في «شرح المفاتيح»(١) التفصيل المتقدم عن ابن زهرة والسيّد الداماد من دون موافقة ولا مخالفة ، فمقتضى ما صنعه التوقف ، قال نقلاً : «ومنها صلاة الزيارة للنبيّ صلى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام وهي ركعتان بعد الفراغ من الزيارة تصلّي عند الرأس على ما وردت به الروايات(٢) .
ولا تصلّي عند قبر رأس أبي الحسن موسى عليه السلام فإنه يقابل قبور قريش ولا يجوز اتّخاذها قبلة ، كذا رواها العبيدي مرفوعاً(٣) ، وإذا زار أمير المؤمنين عليه السلام صلّى ست ركعات لأنّ معه آدم ونوح على ما ورد به الأخبار»(٤) .
قال ابن زهرة في «الغنية» : «وأما صلاة الزيارة للنبيّ صلى الله عليه وآله أو لأحد من الأئمّة عليهم السلام فركعتان عند الرأس بعد الفراغ من الزيارة ، فإن أراد الإنسان الزّيارة لهم وهو في بلده قدم صلاته ثمّ زار عقيبها»(٥) .
__________________
(١) الظاهر أنّ شرح المفاتيح هو (شرح مفاتيح الشرائع) للمولى محمّد الكاشاني ابن المولى محسن الفيض الكاشاني على ما ذكره في الذريعة: ١٤: ٧٨/١٨١٤.
(٢) إلى هنا يظهر أنّه نقل ذلك عن الشهيد في الذكرى: ٤:٢٨٧.
(٣) لم نعثر على هذه الرواية بهذا الخصوص.
نعم ، هناك رواية للعبيدي ـ وهو محمّد بن عيسى بن عبيد ـ ذكرها في الكافي: ٤: ٥٧٨/١ ، إلّا أنّها لم تذكر مسألة الصلاة أصلاً.
(٤) ما ذكره من الصلاة ستّ ركعات هو نقلاً عن الشهيد في الذكرى: ٤: ٢٨٧ ، وكذلك ذكره القاضي ابن البرّاج في المهذّب: ١:١٥٢ ، ولم ينسبه للأخبار.
وذكره ابن زهرة في غنية النزوع: ١٠٩ ، ولم ينسبه للأخبار أيضاً.
نعم ، ذكر صاحب المستدرك عن الشيخ المفيد في مزاره رواية عن صفوان ، عن الصادق عليه السلام في كيفيّة زيارة أمير المؤمنين عليه السلام ، وذكر فيها صلاة ستّ ركعات: ركعتان منها لزيارة أمير المؤمنين عليه السلام وتهدى الأربع ركعات الاُخرى إلى آدم ونوح عليهما السلام.
(٥) غنية النزوع: ١٠٩.
وهذا التفضيل(١) مما قواه السيّد الداماد بعد استضعافه القول بأنّها بعد الفراغ من الزيارة ، سواء كانت تحت القبة أو بعد الشقة ، واحتج على الأوّل(٢) بتظافر الأقوال وتظافر الأخبار.
وعلى الثاني(٣) بما رواه الشيخ في «المصباح» عن الصادق عليه السلام قال : «من أراد أن يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وقبر أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وقبور الحجج عليهم السلام ، وهو في بلده ، فليغتسل في يوم الجمعة ، وليلبس ثوبين نظيفين ، وليخرج إلى فلاة من الأرض ، ثمّ يصلي أربع ركعات يقرأ فيهن ما تيسّر من القرآن ، فإذا تشهد وسلّم فليقم مستقبل القبلة وليقل السّلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » (٤) إلى آخر الحديث ، وما رواه في الفقيه عن هشام عن الصادق عليه السلام ، قال :«إذا بعدت لأحدكم الشقة ونأت به الدار ، فليصعد أعلى منزله ، وليصلّ ركعتين ، وليومِ بالسّلام إلى قبورنا ، فإن ذلك يصل الينا »(٥) .
وقد حكى في «الدرّ المنثور»(٦) أنّه يحكى عن السيّد الداماد التشدّد على تأخّر الصلاة عن الزيارة ، والإصرار على تقدّم الصلاة على الزيارة.
وظاهره القول بتقدّم الصلاة على الزيارة على الإطلاق ، مع أنّك قد سمعت من كلامه بالتفصيل بين القريب والبعيد ، وكذا نقل القول به عن القاشاني.
__________________
(١) الذي ذكر في غنية النزوع.
(٢) مراده بالأوّل: تأخير الصلاة لمن زار عن قُرب.
(٣) مراده بالثاني: تقديم الصلاة لمن زار عن بُعد.
(٤) مصباح المتهجّد: ٢٨٨.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ٢: ٥٩٩/٣٢٠٢.
(٦) الظاهر أنّه الدرّ المنثور في عمل الساعات والأيّام والشهور / الشيخ عليّ بن الحسين الطرحي (المتوفّي سنة ١٣٢٣ هـ. ق) بالنجف الأشرف.
وفي «مفتاح الكرامة» : «أنّ صلاة الزيارة للنبيّ صلى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام ركعتان عند الرأس بعد الفراغ من الزيارة ، فإذا أراد الإنسان الزيارة لأحدهم وهو مقيم في بلده قدّم الصّلاة ثمّ زار عقيبها»(١) .
ومقتضى صريحه التفصيل بين القريب والبعيد أيضاً ، بالقول بتقدّم الزيارة في الأوّل ، وتأخرها في الثاني.
أقول : إنّ مقصود السيّد الداماد ببعض المعاصرين هو شيخنا البهائي ، وهو كثيراً ما يزدري عليه ، لكنّه في الجامع العبّاسي(٢) بنى على تقديم الزيارة مطلقاً ، وحكى عن بعض المجتهدين القول بتقدّم الصلاة في البعيد ، والظاهر أنّه كان بعد واقعة السيّد الداماد ؛ إذ مقتضاها ما نقل عنه السيّد الداماد كمال التحاشي والتوحّش عن تقدّم الصّلاة ، ومقتضاه عدم الاطّلاع على القول بتقدّم الصلاة عن قائل ، وقد حكى في الجامع العبّاسي القول بتقدّم الصلاة للبعيد كما سمعت.
وبعد هذا أقول : إنّ مقصوده من رواية «المصباح» عن علقمة تقدّم الصلاة وتأخّر الزيارة للبعيد هو ضدّ رواية «المصباح» لاختصاصه بالبعيد ، إلّا أنّه مبنيّ على رواية عقبة عن علقمة ، عن أبي جعفر عليه السلام كما تقدم من الوسائل ، وإلاّ فهو قد اشتبه بين عقبة وعلقمة ، مع أنّ الصدر المذكور إنّما يُدل على تأخّر الصلاة عن الزيارة للبعيد ، على أنها معارضة برواية صالح بن عقبة وسيف بن عميرة ، عن علقمة ، عن أبي جعفر عليه السلام كما في ذيل تلك الرواية لدلالتها على تأخّر الزيارة عن الصلاة للقريب والبعيد ، بناء على كون قوله : «فقل» جزاء للشرط كما هو الأظهر ، وكذا معارضة بفعل صفوان وتأخير الصلاة عن الزيارة ، مضافاً إلى أنها موهونة بذيل رواية كامل الزيارة لاختلال حالها أو إجمال أمرها لفظاً من حيث ثبوت الواو وسقوطها ، ومعنى
__________________
(١) مفتاح الكرامة: ٩: ٢٦٦.
(٢) يعني الشيخ البهائي في كتابه «جامع عبّاسي» باللغة الفارسيّة.
قضية أنّ النصّ يوهن بما يتردّد أمره بين المعارضة وعدم المعارضة.
وبعد هذا أقول : إنّه إن كان مقصوده نقل الأخبار الدالّة على التفصيل بين القريب والبعيد ، كما جرى نفسه على التفصيل بينهما ، وكذا نقل الكلام الدال على التفصيل المذكور من الفقها ، فصدر رواية «المصباح» ساكت عن حال القريب ، بعد عدم دلالته على تقدّم الصلاة للبعيد كما مرّ ، ورواية الفقيه وإن كانت دالة على تقدّم الصلاة لكنها ساكتة عن حال القريب ، وعبارة الذكرى دالّة على تقدّم الزيارة على الصلاة للقريب وساكتة عن حال البعيد ، بل مقتضى نقل القول بتقدّم الصلاة عن ابن زهرة للبعيد عدم الاطّلاع على القول بذلك والتوقّف في الباب.
نعم ، عبارة ابن زهرة دالّة على التفصيل بين القريب والبعيد ، لكنّها لا تكفي مستنداً على التفصيل وإن كان مقصوده إبراز ما يدلّ من الأخبار وكلمات الفقهاء على تقدّم الصلاة على الزيارة للبعيد ، بناء على عدم تسليم تقدّم الزيارة على الصلاة للقريب ، كما هو مقتضى قضية المناظرة ، حيث إنها كانت مبنيّة على دعوى المناظر تقدّم الزيارة مطلقاً على الصلاة ، فنقل عبارة الذكرى لا وقع ولا موقع له ، إلّا أن يكون نقلها باعتبار اشتمالها على نقل عبارة ابن زهرة ، لكن هذا الخيال ضعيف الحال لسبق نقل عبارة ابن زهرة من نفسه ، بل نقول إنّه كان عليه ذكر ما يدلّ على تقدّم الزيارة للقريب.
في بيان اسم ابن زهرة الحلبي
بقي الكلام فيما ذكره(١) من أنّه حقّق اسم ابن زهرة في كتاب ضوابط الرضاع.
__________________
(١) يعني المحقّق الداماد ، حيث ذكر في ضمن كلامه السابق المنقول من رسالته (الأربعة الأيّام) أنّه حقّق اسم ابن زهرة في كتابه (ضوابط الرضاع) ، وهذا نصّ عبارته المتقّمة : «ومن اسم او را در كتاب (ضوابط الرضاع) تحقيق كردەام».
فنقول : من باب الحرص على إكثار الفائدة أنّه ذكر في متن الكتاب المسطور(١) : «أنّ ابن زهرة هو السيّد عزّ الدّين حمزة بن علي بن زهرة الحلبي صاحب كتاب «الغنية»(٢) ، وحكى في الحاشية(٣) عن الذكرى في باب صلاة الجماعة أنّه قال : وقال السيّد عزّالدين أبو المكارم حمزة بن عليّ بن زهرة : ولا يصحّ الائتمام بالأبرص والمجذوم والمحدود والزمن والخصي والمرأة ، إلّا لمن كان مثلهم بدليل الإجماع وطريقة الاحتياط ، ويكره الائتمام بالأبرص بالأعمى والعبد ومن لزمه التقصير ومن يلزمه الاتمام والمتيمّم إلّا لمن كان مثلهم.
وكذا حكى(٤) عن ابن شهرآشوب في «معالم العلماء» : أن ابن زهرة حمزة بن عليّ بن زهرة الحسيني الحلبي وكتابه «غنية النزوع» ، وذكر في المتن(٥) أيضاً : أن ابن زهرة عمُّ قدوة المذهب السيّد السعيد محيي الدين ابن حامد محمّد بن عبد الله بن علي بن زهرة.
وفي «الإيضاح» : حمزة بن عليّ بن زُهرة الحسيني بضم الزاي الحلبي ، قال السيّد السعيد صفي الدين بن معد الموسوي رحمه الله(٦) : أنّ له كتاب «قبس الأنوار في
__________________
(١) يعني ضوابط الرضاع.
(٢) واسم الكتاب (غنية النزوع إلى علمي الاُصول والفروع).
(٣) الظاهر أنّ المراد بالحاشية كتاب ضوابط الرضاع ، أي إنّ السيّد الداماد ذكر في حاشية كتاب ضوابط الرضاع
(٤) يعني حكي السيّد الداماد في حاشية كتابه ضوابط الرضاع.
(٥) يعني ذكر السيّد الدامداد في متن كتابه ضوابط الرضاع.
(٦) هو السيّد صفي الدين أبو جعفر محمّد بن معد بن عليّ بن رافع بن أبي الفضائل ، وينتهي نسبه إلى الإمام موسى الكاظم عليه السلام ، ترجم له الحرّ العاملي في أمل الآمل: ٢: ٣٠٧/٩٢٩. لم نعثر له على كتاب ، والظاهر أنّ العبارة المنقولة هنا مأخوذة من كتاب العلّامة إيضاح الاشتباه في ترجمة ابن زهرة ، فراجع إيضاح الاشتباه ترجمة رقم ٢٤٣.
نصرة العترة الأخيار» وكتاب «غنية النزوع».
وفي «الأمل»(١) في باب الكنى : «ابن زهرة حمزة بن عليّ بن زهرة».
وعن «رياض العلماء»(٢) : «أنّه حُكي عن بعضٍ نسبة كتاب الوسيلة إلى السيّد حمزة يعني ابن زهرة ، قال : وهو غلط فاحش»(٣) .
__________________
(١) المراد به أمل الآمل على ما هو الخطأ الشائع ، وإلّا فاسم الكتاب (تذكرة المتبحّرين) ، حيث إنّ الشيخ الحرّ ألّف أوّلاً كتابه الموسوم بـ (أمل آمل في علماء جبل عامل) ، وهو الموسوم بالقسم الأوّل من كتاب (أمل الآمل) ، وثانياً ألّف كتابه المسمّى بـ (تذكرة المتبحّرين في العلماء المتأخّرين) وهو الموسوم بالقسم القسم الثاني من كتاب (أمل الآمل) ، حيث إنّه خصّ هذا الكتاب بذكر من عدا علماء جبل عامل.
وعلى كلّ حال ، ما ذكره المصنّف هنا عن المحقّق الداماد هو ما ذكره الحرّ في القسم الثاني من كتاب (أمل الآمل) ، والصحيح أنّه (تذكرة المتبحّرين) ، ذكر ذلك في فصل فيما يبدأ ـ«ابن».
(٢) رياض العلماء وحياض الفضلاء للمولى عبدالله أفندي الأصفهاني ، من أعلام القرن الثاني عشر ، وهو من تلامذة العلّامة المجلسي ، توفّي صاحب الرياض سنة ١١٣٠ هـ. ق. كتب السيّد شهاب الدين المرعشي النجفي قدس سره ترجمة مختصرة له أسماها (زهر الرياض في ترجمة صاحب الرياض) ، وهي مذكورة في مقدّمة كتاب الرياض.
(٣) بعد تتبّع الرياض في ترجمة ابن زهرة وابن حمزة لم نعثر على هذا الكلام ، وإنّما المذكور في الرياض هو نقله نسبة كتاب الوسيلة إلى أبي يعلى محمّد بن الحسن بن حمزة الجعفري ، حيث قال في الرياض ما نصّه : «أقول : بما ذكرنا من هذا التفصيل قد ظهر فساد كلمات طائفة من أهل العصر ومن تقدّمهم في نسبة كتاب الوسيلة إلى أبي يعلى المذكور ثانياً ، وفي جعل صاحب الوسيلة تلميذ المفيد ، وفي نحو ذلك من الخلط والخبط فلا تغفل».
ولعلّ هذا هو مراد المصنّف ، فلا تغفل.
في بيان المراد بابن حمزة
وهو(١) قد ذكر أنّ المراد بابن حمزة في الأغلب الشيخ الأجل الفقيه عماد الدين أبو جعفر محمّد بن عليّ بن حمزة بن محمّد المشهدي الطوسي المعروف بابن حمزة(٢) وبأبي جعفر الثاني وبأبي جعفر الطوسي المتأخّر ، وهو صاحب «الوسيلة» وغيره من المؤلّفات ، قال : وقد يطلق أيضاً على الشيخ نصيرالدين علي بن حمزة بن الحسن الطوسي. ويطلق أيضاً نادراً على الشيخ نصير الدين عبد الله بن حمزة بن الحسن بن علي الطوسي المشهدي اُستاذ قطب الدين الكيدري ، وهما أيضاً من سلسلة ابن حمزة الأوّل ، وقد سهى شيخنا المعاصر(٣) في باب الكنى من أمل
__________________
(١) يعني به صاحب الرياض ، والذي نقله المصنّف هنا مضمون عبارة الرياض ، وعلى كلّ حال ترجم صاحب الرياض لابن حمزة في موضعين من كتابه رياض العلما :
الموضع الأوّل : ٥: ١٢٢ ، فكان بداية ما ذكره في ترجمته : «الشيخ الإمام عماد الدين أبو جعفر محمّد بن عليّ بن حمزة الطوسي المشهدي ، فقيه ، عالم ، واعظ ، له تصانيف منها الوسيلة ...».
والموضع الثاني : ٦: ١٦ ، في الفصل الذي عقده للكنى المصدّرة بـ«ابن» من الخاصّة ، فكان بداية ما ذكره في ترجمته : «ابن حمزة : يطلق على جماعة ، وفي الأغلب الأشهر يراد منه الشيخ أبو جعفر الثاني الطوسي المتاخّر صاحب الوسيلة وغيرها في الفقه ، أعني الشيخ الإمام عماد الدين أبو جعفر محمّد بن عليّ بن حمزة الطوسي المشهدي الفقيه المعروف ...». إلى أن قال : «وقد مات سنة ثلاث وستّين وأربعمائة في يوم السبت سادس عشر رمضان ...» ، والظاهر أنّ ما نقله المصنّف هنا عن الرياض من الموضع الثاني.
(٢) وعن المحقّق الكركي في بعض إجازاته أنّ اسم ابن حمزة : هبة الله ، وهو من علماء حلب ، قيل : كلّاً من الأمرين غريب لم يذكره غيره ، ولم أدرِ من أين أخذه ، إلّا من اجتهادات نفسه ومتفرّدات وهمه وحدسه. منه رحمه الله.
(٣) المراد به الحرّ العاملي ، حيث إنّه ترجم لابن حمزة في موضعين من كتابه (تذكرة المتبحّرين) الذي سمّاه المصنّف بـ (أمل الآمل) ، ولعلّ ذلك تغليباً ، فذكره أوّلاً»
الآمل ، وغيره في غيره فجعلوا المشهور بابن حمزة هو الشيخ الجليل الحسن بن حمزة الحلبي
أقول : إنّه يترائى بادي الرأي أن ابن حمزة الثاني والده ابن حمزة الأوّل ، لكن قوله(١) : (وهما أيضاً من سلسلة ابن حمزة الأوّل) يضائق عنه ، إذ لا يطلق على ولد الشخص أنّه من سلسلته ، فعليّ بن حمزة في الثاني(٢) غير عليّ بن حمزة في الأوّل(٣) ، مُضافاً إلى أنّ عليّاً في الأوّل سبط(٤) محمّد وفي الثاني سبط الحسن ، فلا مجال لتوهّم اتّحاد عليّ في الأوّل مع عليّ في الثاني.
__________________
«بقوله : «الشيخ الجليل الحسن بن حمزة الحلبي ، كان عالماً فاضلاً ، فقيهاً جليل القدر» ص ٦٥ ترجمة ١٧٥ ، وثانياً في باب الكنى ، فقال : «ابن حمزة : اسمه الحسن».
(١) يعني به قول رياض العلماء في العبارة المذكورة.
(٢) وهو الذي ذكره في الرياض بقوله : «وقد يطلق أيضاً على الشيخ نصير الدين عليّ بن حمزة بن الحسن الطوسي».
(٣) هو والد محمّد المترجم له حيث ذكر «أبو جعفر محمّد بن عليّ بن حمزة بن محمّد المشهدي الطوسي ، المعروف بابن حمزة» ، فعليّ بن حمزة في الأوّل هو : عليّ بن حمزة بن محمّد ، بينهما عليّ بن حمزة في الثاني هو : عليّ بن حمزة بن الحسن.
(٤) السبط : هو ولد الولد الذي يشمل ولد الابن وولد البنت ، وقيل : ولد البنت خاصّة ، وولد الابن حفيد
[التنبيه] الثالث :
فيما ذكره العلّامة المجلسي قدس سره في زاد المعاد
من أن الأحوط في زيارة عاشوراء تقديم زيارة أمير المؤمنين عليه السلام
إنّ العلّامة المجلسي عليه السلام صرّح في «زاد المعاد» بعد الكلام المتقدّم منه في بيان الاحتياط : أن الأحوط(١) تقديم زيارة أمير المؤمنين عليه السلام على زيارة عاشوراء ، خصوصاً إذا كان زيارة عاشوراء عند قبر أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : «واﮔﺮ زيارت أمير المؤمنين عليه السلام با اين زيارت(٢) ضمّ كند بهتر است خصوصاً هرﮔﺎه اين زيارت را نزد ضريح امير المؤمنين عليه السلام بعمل آورد»(٣) ، وهو مقتضى كلامه في «تحفة الزائر» عند الكلام في زيارات أمير المؤمنين عليه السلام بعد الفراغ عن الزيارة السادسة ، إلّا أنّه لم يذكر أولويّة الاحتياط لو كان زيارة عاشوراء عند قبر أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : «وﭼﻮﻥ اين حديث مشتمل بر فضيلت عظيم(٤) است بهتراست كه هرﮔﺎه خواهند اين زيارت بعمل آورند خواه در روز عاشوراء وخواه در غير آن وخواه نزد قبر أمير المؤمنين عليه السلام وخواه نزد قبر إمام حسين عليه السلام وخواه در ساير بلاد أوّل زيارت أمير المؤمنين عليه السلام بكند تا آنجا كه (فإنّي عبد الله ووليّك وزائرك صلّى الله عليك)(٥) ﭘﺲ ابتدا كند
__________________
(١) الظاهر أنّ تعبير المصنّف عمّا فعله العلّامة المجلسي بالاحتياط تعبير مسامحي ، حيث إنّ العلّامة لم يعبّر بالاحتياط ، وإنّما عبّر بالأفضل ، حيث قال : «بهتر است» ، وفرّق بينهما.
(٢) قوله : «باين زيارت» كان المناسب أن يقول : «به اين زيارت». منه رحمه الله.
(٣) ترجمة المقطع الفارسي : «ولو ضمّ زيارة أمير المؤمنين عليه السلام إلى هذه الزيارة فهو أفضل ، خصوصاً إذا جاء بهذه الزيارة عند مرقد أمير المؤمنين عليه السلام».
(٤) قوله : «عظيم» كان المناسب أن يقول : «عظيمه». منه رحمه الله.
(٥) قوله : «صلّى الله عليك» كان المناسب أن يزيد «است» ، وإلّا فالكلام ناقص. منه رحمه الله.
وزيارت حضرت امام حسين عليه السلام را بتمام آن زيارتى كه در اوّل زيارت عاشورا بيان خواهم كرد بخواند بهمه حديث عملكرده باشد»(١) .
في أن مقتضى كلام العلّامة المجلسي قدس سره في «تحفة الزائر»
أن الاحتياط في الزيارة السادسة تعقيبها بزيارة عاشوراء
حيث إن متقضاه كون الأوْلى في زيارة أمير المؤمنين عليه السلام بالزيّارة السادسة تعقيبها بزيارة عاشوراء ، وهذا وإن [كان] لا يستلزم كون الأوْلى في زيارة عاشوراء تعقيبها للزيارة السادسة ، لكن مقتضى تعليله الأولويّة في باب الزيارة السادسة أعني كون الأوْلى تعقيبها بزيارة عاشوراء بالعمل بتمام الحديث هو الأولوية في باب زيارة عاشوراء بكون الأوْلى تقديم الزيارة السادسة عليها ، وتظهر هذه المقالة من قوله في «البحار» بعد الفراغ عن الزيارة السادسة : «أقول : سيأتي تمامها في زيارات الحسين عليه السلام فإن عمل بجميعها كان أفضل»(٢) .
والظاهر أنّ المقالة المشار إليها متابعته للسيّد ابن طاووس قدس سره ، حيث إنّه على ما نقل عنه في «البحار» قال بعد ذكر الزيارة السادسة : «ثمّ صلّى صلاة الزيارة ستّ ركعات له ولآدم ونوح عليهم السلام لكلّ واحد منهم ركعتان ، ثم قم فزر الحسين عليه السلام من عند رأس أمير المؤمنين عليه السلام بالزيارة الثانية من زيارتي عاشوراء اتّباعاً لما ورد
__________________
(١) ترجمة المقطع الفارسي : «وبما أنّ هذا الحديث مشتمل على فضائل عظيمة ، فمن الأفضل أن يقدّم زيارة أمير المؤمنين عليه السلام متى أراد أن يزور بهذه الزيارة ، سواء في يوم عاشوراء وغيره ، وسواء عند قبر أمير المؤمنين عليه السلام ، أو عند مرقد الإمام الحسين عليه السلام ، أو في أي مكان إلى قوله : «فإنّي عبد الله ووليّك وزائرك ، صلّى الله عليك» يبدأ بزيارة الإمام الحسين عليه السلام كاملة ، كما سنذكره في بداية زيارة عاشوراء حتّى يكون عمل بكلّ الحديث.
(٢) بحار الأنوار : ٩٧: ٢٩٣.
إن شاء الله»(١) .
وقد تقدم من المحقّق القمّي وبعض من تأخّر عنه الاحتياط بتقديم الزيارة السادسة على زيارة عاشوراء أيضاً ، وتقدّم من بعضٍ أن الأوْلى تقديم زيارة أمير المؤمنين عليه السلام على زيارة عاشوراء ، والغرض الاحتياط بالتقديم.
أقول : إن مقتضى كلام العلّامة(٢) المشار إليه في «التحفة» أنّ الفضل العظيم في الجمع بين الزيارتين ، كما هو الظاهر من بيان الفضل بقوله عليه السلام : «فإني ضامن على الله لكل من زارهما بهذه الزيارة ودعا بهذا الدعاء » ، لكن عمدة الفضل مذكورة بعد ذلك في الذيل في طيّ بيان فضل زيارة مولانا الحسين عليه السلام في قوله : «فآلى الله على نفسه عزّ وجلّ أن من زار الحسين بن علي عليه السلام » ، بل يمكن القول : بأنّ الذيل يكشف عن كون الفضل المذكور في الصدر باعتبار الجزء الأخير أعني زيارة مولانا الحسين عليه السلام ، بل يرشد إلى هذا أعني كون الفضل في الصدر باعتبار الجزء الأخير إفراد الضمير في قوله : «وزرته» ، وتخصيص الفضل في الصدر من البدو وإلى الختم في رواية «المصباح» بزيارة مولانا سيّد الشهداء عليه السلام ، بل نقول : إنّ قوله : «هذه الزيارة » في الصدر في قوله عليه السلام : «يا صفوان ، تعاهد هذه الزيارة » وقوله عليه السلام : «يا صفوان ، وجدت هذه الزيارة مضمونة » إشارة إلى الزيارة الأخيرة أعني زيارة عاشوراء.
إلّا أن يقال : إن مقتضى قوله عليه السلام : «وزرهما بهذه الزيارة » ، وقوله عليه السلام «لكل من زارهما بهذه الزيارة » مُطلق الزيارة الأعم من الزيارتين.
وبعد هذا أقول : إنّه لا أقلّ في الباب من معارضة تثنية الضمير في رواية محمّد بن المشهدي بالإفراد في رواية «المصباح».
إلّا أن يقال : إنّ المعارضة لا تنافي الاحتياط في الجمع.
__________________
(١) بحار الأنوار : ٩٧: ٣١٠.
(٢) يعني به العلّامة المجلسي رحمه الله.
وبعد هذا أقول : إنه لا مجال لخيال مداخلة إحدى الزيارتين ، أعني الزيارة السادسة وزيارة عاشوراء في صحة الأخرى أو كمالها ، وإنّما الجمع بينهما من مولانا الصادق عليه السلام كان من باب البخت والاتفاق وكان من صفوان من باب المتابعة.
وبعد هذا أقول : إن فعل الصادق عليه السلام إما إنّه كان في يوم عاشوراء أو في غير بوم عاشوراء ، وعلى هذا المنوال فعل صفوان.
وعلى الأوّل(١) يكون رواية صفوان معارضة برواية مالك وعلقمة وعقبة لخلوّها عن اشتراط سبق زيارة أمير المؤمنين عليه السلام من الزيارة السادسة أو غيرها والترجيح مع رواياتهم بكونها أكثر ، بل نقول : إنّه لو كان سبق زيارة أمير المؤمنين عليه السلام دخيلاً في زيارة عاشوراء صحةً أو كمالاً لما خلى عنه أخبارها لشدّة الاهتمام بها.
وعلي الثاني(٢) نقول : إن رواية صفوان معارضة بالرواية الواردة في زيارة سيّد الشهداء عن البعد ، وكذا الروايات الواردة في آداب زيارته عليه السلام لخلوّها عن اعتبار سبق زيارة أمير المؤمنين عليه السلام.
وإن قلت : إن المقيد يقدّم علي المطلق.
قلت : إنّه لو كان المطلق في مجالس عديدة فيقدّم المُطلق ، على ما حرّرناه في الاُصول ، مع أنّه لو كان فعلٌ مأخوذاً في فعلٍ واجبٍ أو مستحبٍ من النبيّ صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام أو سابقاً أو لاحقاً ، فيحتمل في الواجب كون الأمر من باب الواجب التعبدي وفي المستحب من باب المستحب في المستحبّ ، كما هو مقتضى طائفة من الكلمات ، فمجرّد سبق زيارة أمير المؤمنين عليه السلام لا يدلّ على الاشتراط ، بل يحتمل كون الأمر من باب المستحب في المستحب.
إلّا أن يقال : إنّ الظاهر من الفعل المأخوذ في الفعل ، كون الأمر من باب
__________________
(١) أي كون فعل الصادق عليه السلام وصفوان في يوم عاشوراء.
(٢) أي كون فعل الصادق عليه السلام وصفوان في غير يوم عاشوراء.
الاشتراط والجزئية.
لكن نقول : إنّ حجيّة هذا الظن مبنية على حجيّة مطلق الظنّ ، أو على حجّيّة الظنّ الناشئ من الفعل ، مع أنّ الظاهر في المقام كون الأمر من باب البخت والاتّفاق ، فلا دلالة في سبق زيارة أمير المؤمنين عليه السلام من الصادق عليه السلام على الاشتراط.
وبالجملة فالمظنون عدم مداخلة زيارة أمير المؤمنين عليه السلام في زيارة عاشوراء ، وبالعكس فالاحتياط في زيارة عاشوراء بتقديم الزيارة السادسة عليها من قبيل الوسواس ، واحتمال سقوط سقف محكم الأساس ، وعلى هذا القياس والمقياس الاحتياط في الزيارة السادسة بالحاق زيارة عاشوراء.
[التنبيه] الرابع :
في أن مقتضى كلام السيّد الداماد لزوم إتمام زيارة عاشوراء
وغيرها من زيارات المعصومين عليهم السلام
بستبيح فاطمة الزهراء سلام الله عليها بالمعنى الغير معروف
إنّ مقتضي كلام السيّد الداماد في الرسالة المتقدّمة(١) لزوم إتمام زيارة عاشوراء وغيرها من زيارات المعصومين بتسبيح فاطمة الزهراء سلام الله عليها بالمعنى الغير المعروف ، وهو :
«سبحان ذي الجلال الباذخ العظيم ، سبحان ذي العزّ الشامخ المنيف ، سبحان ذي الملك الفاخر القديم ، سبحان ذي البهجة والجمال ، سبحان من تردّى بالنُّور والوقار ، سبحان من يرى أثر النّمل على الصّفا ووقع الطير في الهواء» ، قال نقلاً بالفارسية : «مسئلة بايد دانست كه تسبيح فاطمة زهراء سلام الله عليها در احاديث اهل بيت طاهرين صلوات الله وتسليماته عليهم ودر اطلاقات اصحاب قدّس الله تعالى اسرارهم دو اطلاق دارد بر سبيل اشتراك لفظ اوّل آنكه بحسب اصطلاح شايع ومتعارف(٢) كه عبارت از سى وﭼﻬﺎر تكبير وسى وسه تحميد وسى وسه تسبيح
__________________
(١) الأربعة الأيّام.
(٢) قوله : «شايع ومتعارف» يترائ بادي الرأي كونه صفة للاصطلاح ، وكون الاصطلاح مكسوراً كما هو الحال في باب التوصيفات في اللغات الفارسيّة ، لكن على هذا يختلّ المعنى ، فلعلّ قوله المشار إليه بمنزلة الخبر ، لقوله : «آنكه» ، فالاصطلاح على وجه السكون ، والأمر بمنزلة أن يقال ما يكون بحسب الاصطلاح شائعاً ومتعارفاً ، فقد حذف في المقام لفظ «است» ، وهو أداة النسبة الخبريّة في اللغات الفارسيّة شايع ومتعارف»
است بطريق مشهور در تعقيبات صلوات سنّت مؤكده است وأفضل أفراد تعقيب است باتّفاق اصحاب وعلماى جمهور دوّم تسبيحى عظيم المرتبه است كه در اوراد وأدعيّه از سيّدة النساء صلوات الله عليها تكرار آن وارد ودر زيارت معصومين بعد از اتمام وظيفه زيارت اتيان بان لازم است ودر اصول معتبره حديث وكتب مسنده مشيخه رضوان الله تعالى عليهم اسانيد صحيح دارد وآن تسبيح اين است كه :(سبحان ذي الجلال الباذخ العظيم ، سبحان ذي العزّ الشامخ المنيف ، سبحان ذي الملك الفاخر القديم ، سبحان ذي البهجة والجمال ، سبحان من تردّى بالنور والوقار ، سبحان من يرى أثر النمل في الصفا ووقع الطير في الهواء) ابناء عصر ما بنابر قصور تتبع ونقصان تمهر از اين اصطلاح در تسبيح فاطمه زهرا عليها السلام غافل بودند وهرجا تسبيح مذكور شده است بطريق مشهور وحمل ميكردند تا آنكه من ايشان را تنبيه كردم يا انكه عروة الاسلام أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه رضوان الله تعالى عليه دو باب زيارت أمير المؤمنين عليه السلام از كتاب من لا يحضره الفقيه ذكر ان كرده بعداز زيارت وداع باين عبارت ﮔﻔﺘﻪ است وتسبح تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام وهو : (سبحان ذي الجلال الباذخ العظيم ، سبحان ذي العزّ الشامخ المنيف ، سبحان ذي الملك الفاخر القديم ، سبحان ذي البهجة والجمال ، سبحان من تردى بالنور والوقار ، سبحان من يرى اثر النمل في الصفا ووقع الطير في الهواء ) ، وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ غير او از شيوخ ومشايخ ذكر كرده اند ونيز در بسيارى از كتب ادعيه بعد از ايراد تسبيح زهرا عليها السلام بطريق مشهور نيز واقع شده است ثم تسبّح تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام».
أقول : إنّ دعوى لزوم الإتيان بتسبيح فاطمة الزهراء سلام الله عليها بالمعنى الثاني إتماماً للزيارة فضلاً عن الزيارات غير معقول ، إذ الزيارة مندوبة ولو لزم
__________________
«بل هو أجمل من الذكر ، فكان الأصل «آنكه» بحسب اصطلاح شائع ومتعارف ، ويرشد إلى ما ذكر قوله بعد ذلك : «تكرار آن وارد». منه رحمه الله.
التسبيح المشار إليه إتماماً للزيارة يلزم مزية الفرع على الأصل.
إلّا أن يقال : إنّ المقصود باللزوم هو الاشتراط.
أو يقال : إنّ المستحيل إنّما هو وجوب جزء المندوب أو شرطه من جهة الجزئية والشرطية أعني تحصيل المندوب ، وأمّا وجوب الجزء أو الشرط بنفسه فلا بأس به ، سواء كان الوجوب مطلقاً كما في الإيمان ، حيث إنّه شرط لصحّة العبادات المندوبة كالواجبة ، أو كان الوجوب مشروطاًكما في المقام ، حيث إنّ مرجع الأمر إلى وجوب الطهارة على تقدير إرادة الإتيان بالمندوب.
وبوجه آخر : ما يستحيل إنّما هو مزيّة الفرع على الأصل من جهة الفرعيّة ، وأمّا مزيّتها بنفسها فلا بأس بها ، ولا بأس بوجوب جزء المندوب أو شرطه على تقدير الإتيان بالمندوب ، كالطهارة للصّلاة ، كما أنّه لا بأس بوجوب الإيمان مع اشتراط العبادات المندوبة بها.
ويرشدك إلى المقالتين(١) ما ذكره الشهيد في القواعد : من أن «الأصل في هيئات المستحبّ أن تكون مستحبّة لامتناع زيادة الوصف على الأصل ، وقد خولف في مواضع
منها : الترتيب في الأذان وصفه الأصحاب بالوجوب.
ومنها : رفع اليدين بالتكبير في جميع تكبيرات الصلوات وصفه المرتضى بالوجوب
ومنها : وجوب القعود في النافلة أو القيام تخييراً إن قلنا بعدم جواز الاضطجاع ، وهذا وترتيب الأذان الوجوب بمعنى الشرط.
__________________
(١) وهما اللتان أشار إليهما بقوله : «إلّا أن يقال : إنّ المقصود باللزوم ، أو يقال : إنّ المستحيل ....»
ومنها : وجوب الطهارة للصلاة المندوبة ويسمى الوجوب غير المستقر»(١) .
ومحصوله(٢) كما ذكره السيّد الداماد في عيونه(٣) على ضربٍ ما من التفصيل : بأن بعضاً مما يشترط به المستحبّاب بحيث إذا أتى بالمشروط من دونه لم يتحقّق حقيقة المشروط ، لكنّه لم يستوجب ترتب العقاب أصلاً ، وهذا مثل ترتيب الأذان والقيام أو القعود تخييراً في النافلة وبعضاً منه بحيث إذا ترك مع الإتيان بالمشروط منع عن تحقّق المشروط وأوجب ترتّب العقاب ، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة المندوبة ، فإذا أطلق الوجوب على القسم الأوّل أريد مجرّد الشرطية فإنّه يضاهي الواجب في أنّه لا بدّ منه في تحقّق المشروط ، وأن أطلق على القسم الثاني اُريد الوجوب الغير المستقرّ ، بمعنى أنّ تركه يُوجب العقاب على تقدير الإتيان بالمشروط ، فهو يضاهي الواجب في إيجاب تركه للعقاب.
وحاصل هذا المحصول : أنّ المقصود بالوجوب الاشتراط في باب الترتيب في الأذان ورفع اليدين بالتكبير ووجوب القعود في النافلة أو القيام تخييراً ، والوجوب الغير المستقرّ في باب الطهارة للصلاة. لكن عن فخر المحقّقين القول بالوجوب بالمعنى المعروف في باب ترتيب الأذان.
ويرشد إلى وجوب الطهارة للصلاة : ما رواه في الوسائل عن الصدوق بإسناده عن مسعدة بن صدقة ، قال : «إن قائلاً قال لجعفر بن محمّد عليهما السلام : جُعلت فداك ، إنّي أمرّ بقوم ناصبيّة وقد اُقيمت لهم الصلاة وأنا على غير وضوء ، فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاءوا أن يقولوا ، فاُصلّي معهم ثمّ أتوضّأ إذا انصرفت واُصلّي.
فقال جعفر بن محمّد عليهما السلام :سبحان الله! أفما يخاف من يُصلّي من غير وضوء أن
__________________
(١) القواعد والفوائد : ٢: ٣٠٣ ، قاعدة ٢٨٨.
(٢) محصول ما أفاده الشهيد في قواعده.
(٣) عيون المسائل / المحقّق الداماد.
تأخذه الأرض خسفاً »(١) .
وكذا ما رواه في الوسائل عن الصدوق في «العلل» و «عقاب الأعمال» بسنده عن صفوان بن مهران الجمّال ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : «اُقْعِدَ رجلٌ من الأحبار في قبره فقيل له : إنّا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله.
فقال : لا اُطيقها ، فلم يفعلوا حتّى انتهوا إلى جلدة واحدة ، فقالوا : ليس منها بدٌّ ، قال : فبما تجلدونيها؟
قالوا : نجلدك إنّك صلّيت يوماً بغير وضوء ، ومررت على ضعيف فلم تنصره ، فجلدوه جلدة من عذاب الله فامتلأ قبره ناراً»(٢) .
ورواه البرقي بسنده عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبد الله عليه السلام.
وهو مروي في الفقيه مرسلاً بإبهام الواسطة ، أي بقوله روي.
لكن يتأتّى الإشكال فيه : من جهة ظهوره في كون العذاب على مجموع ترك الطهارة وترك نصرة المظلوم.
لكنّه مدفوع : بتأتّي المداخلة في العذاب ، مع كون العذاب على المجموع وفيه الكفاية في المقصود.
نعم يتأتّى الإشكال من جهة أن الحِبْر عالم اليهود ، على ما يقتضيه صريح الصحاح(٣) ، فيبتني انتهاض الاستدلال على اعتبار شرع من سبق ، بل لو كان الحِبْر
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١: ٣٦٧ ، الباب ٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.
(٢) وسائل الشيعة : ١: ٣٦٨ ، الباب ٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.
(٣) قال الجوهري في «الصحاح ـ مادة حبر» : «والحِبْرُ والحَبْرُ : واحد أحبار اليهود ، وبالكسر أفصح ، لأنّه يجمع على أفعال دون الفعول. قال الفرّاء : هو حِبْرٌ بالكسر ، يقال ذلك للعالم ...». إلى أن قال : «قال الأصمعي : لا أدري هو الحِبْر أو الحَبْر ، للرجال العالم» صحاح الجوهري : ٢: ٦٢٠.
بمعنى العالم ، كما قيل فينصرف إلى عالم اليهود ، فيبتني انتهاض الاستدلال على ما ذكر ، فتدبّر(١) .
وندفع المقالة الاُولى(٢) : بأن اشتراط إتمام الزيارة بالتسبيح المذكور في عموم الزيارات غير بيّن ولا مبين.
إلّا أن يقال : إنّ المقصود بالجمع المضاف في كلامه(٣) ـ أعني زيارات معصومين ـ هو الطائفة من الزيارات التي ورد فيها التسبيح ، كما يأتي.
لكنّك خبير بأنّه يستلزم تخصيص الأكثر.
وأمّا المقالة الثانية (٤) : فلا تجدي في الباب لأنّها مبنيّة على الثبوت ، ولم يثبت في المقام وجوب التسبيح.
وبعد ذلك أقول : إنّ ظاهر كلامه تسليم كون التسبيح بالمعنى الأوّل المعروف بين أربع وثلاثين تكبيرة ، وثلاث وثلاثين تحميدة ، وثلاث وثلاثين تسبيحة(٥) ، مع اختلاف الأخبار والأقوال في باب التسبيح بالمعنى المشار إليه عدداً وترتيباً ، إذ مقتضى بعض الأخبار أنّه : ثلاث وثلاثون تسبيحة ، وثلاث وثلاثون تحميدة ، وثلاث وثلاثون تكبيرة(٦) .
__________________
(١) قوله : «فتدبّر» إشارة إلى إمكان منع الانصراف. منه رحمه الله.
(٢) وهي قوله المتقدّم : «إلّا أن يقال : إنّ المقصود باللزوم هو الإشتراط».
(٣) يعني به كلام المحقّق الداماد المتقّدم الذكر.
(٤) وهي قوله المتقدّم : «إنّ المستحيل إنّما هو وجوب جزء المندوب أو شرطه من جهة الجزئية والشرطيّة»
(٥) كما هو مقتضى بعض الأخبار ، منها ما رواه في وسائل الشيعة : ٦: ٤٤٤ ، الباب ١٠ من أبواب التعقيب ، الحديث ٢.
(٦) كما هو مقتضى ما رواه في وسائل الشيعة عن العلل ، فراجع وسائل الشيعة : ٦: ٤٤٤ ، الباب ١١ من أبواب التعقيب ، الحديث ٣.
ومقتضى بعض آخر من الأخبار أنه : أربع وثلاثون تكبيرة ، وسبع وستون تحميدة ، ومائة تسبيحة(١) .
وعن ظاهر الصدوق في طائفة من كتبه أنّه : أربع وثلاثون تكبيرة ، وثلاث وثلاثون تسبيحة ، وثلاث وثلاثون تحميد(٢) . وعن بعض أنّه تسعة وتسعون(٣) .
وإن قلت : إن مقصوده(٤) المشهور ، بشهادة قوله بطريق مشهور.
قلت : إنّ المقصود من الشهرة فيه إنما هو الشهرة في قبال المعنى الثاني للتسبيح ، كما يرشد إليه قوله «بحسب اصطلاح شايع ومتعارف» وليس الغرض الشهرة بحسب الفتوى فلا ينافي الاتّفاق في الفتوى.
في أن المعمول(٥) لتسبيح فاطمة الزهراء سلام الله عليها
لا يوافق شيئاً من الأخبار والأقوال
وبما ذكرنا بانَ أن ما عُمِلَ للتسبيح من ثلاث وثلاثين واثنتين وثلاثين وثلاث
__________________
(١) كما هو مقتضى ما رواه في الوسائل عن الكافي ، فراجع وسائل الشيعة : ٦: ٤٤٤ ، الباب ١٠ من أبواب التعقيب ، الحديث ١.
(٢) فراجع في ذلك الهداية للشيخ الصدوق : ١٤١ ، باب تسبيح الزهراء عليها السلام. والمقنع : ٩٧ ، باب تسبيح الزهراء عليها السلام.
(٣) الظاهر أنّ مراده مجموع تسبيح الزهراء عليها السلام يكون كذلك ، وهذا المعنى ورد في بعض روايات العامّة ، كما عن مجمع الزوائد ، عن أبي هريرة ، فراجع المجمع : ١٠:١١٠.
(٤) يعني به المحقّق الداماد في كلامه المتقدّم.
(٥) يشير المصنّف هنا إلى المسبحة التي يكون المجموعة الاُولى فيها ثلاثة وثلاثين ، ثمّ يأتي مفصل (وهو ما يعبّر عنه بالعاميّة شاهد) ، ثمّ المجموعة الثانية فيها اثنين وثلاثين ، ثمّ يأتي مفصل ، ثمّ المجموعة الثالثة فيها وثلاثين ، ويظهر من كلام المصنّف أنّ هذا النوع من المسابح صنعت في زمان المحقّق الداماد.
وثلاثين مع مِفْصَلٍ بين ثلاث وثلاثين واثنتين وثلاثين يشبّه بالعدس ويسمّى بالفارسية بـ (عدسي) ، لا يوافق شيئاً من الأقوال والأخبار ، إذ مقتضاه كون التسبيح بين ثلاث وثلاثين تكبيرة واثنتين وثلاثين تحميدة وثلاث وثلاثين تسبيحة ، وعليه عمل العوام ، بل الأكثر من غيرهم بلا كلام ، والظاهر أنّ المعمول للتسبيح كان على الوجه المذكور من بدو زمانه(١) ، وكان على العلماء(٢) التنبيه على فساده.
وما ربما يتوهم من أن الغرض من المفصل الدلالة على الإنفصال مع إتمام عدد التكبيرة والتحميدة(٣) .
ليس بشيء ، كيف ولايعرف أحد من العوام الدلالة على الإتمام ، بل لو كان الغرض هو ما ذكر لما كان غرضاً صحيحاً ، إذ لا يستفاد من المفصل غير الإنفصال ، مع أنه ليس جعل المفصل إتماماً للتكبيرة والتحميدة أولى من جعل كل من المفصلين إتماماً للتسبيحة ، أو جعل أحد المفصلين إتماماً للتكبيرة وجعل الآخر إتماماً للتحميدة ، فكان اللازم جعل المفصل بعد أربع وثلاثين وكذا بعد ثلاث وثلاثين.
وبعد هذا أقول : إن ظاهر كلامه إجمال التسبيح بواسطة اشتراكه لفظاً ، لكن اشتراكه لا ينافي الظهور في المعنى الأوّل بواسطة الشهرة ، بناء على كون الشهرة
__________________
(١) يعني به زمان المحقّق الداماد.
(٢) وقد سمعت أنّ في بعض ما عمل كان المفصل بعد أربع وثلاثين وبعد ثلاث وثلاثين. منه رحمه الله.
(٣) يعني بما أنّ المجموعة الاُولى ثلاثة وثلاثين ومع المفصل الأوّل تكون أربع وثلاثين ، والمجموعة الثانية اثنين وثلاثين ومع المفصل الثاني تكون ثلاثة وثلاثين ، والمجموعة الثالثة هي ثلاثة وثلاثين ، فتكون المجموعة الاُولى أربعاً وثلاثين تكبيرة ، والثانية ثلاثة وثلاثين تحميدة ، والثالثة ثلاثة وثلاثين تسبيحة ، وهذا هو المشهور.
من المرجح في باب المشترك ، كما هو الحق على ما حرّرناهٍُ في الاُصول خلافاً للمحقق القمّي.
إلّا أن يقال : إن الترجيح بالشهرة في المشترك إنما هو فيما لو كان الشهرة متحققة في عرف المتكلم بالمشترك بكثرة استعمال المشترك في عرفه في أحد المعنيين ، وأما فيما نحن فيه فليس الأمر على هذا المنوال لعدم كثرة استعمال التسبيح في المعنى الأوّل في الأخبار.
إلّا أن يقال : بعدم لزوم كثرة الإستعمال في عرف المتكلّم وكفاية غلبه الوجود في الخارج.
لكن لعل الأظهر أن يقال : إن الظاهر في موارد الزيارة كون الغرض من تسبيح الزهراء سلام الله عليها فيما لم يذكر فيه لتفسير التسبيح هو المعنى الثاني.
وبعد هذا أقول : إن ما ذكره من أنّه في كثير من كتب الأدعية بعد إيراد التسبيح بالمعنى المشهور «قبل ثمّ تسبّح تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام» تقتضي ظهور فساد العطف ؛ إذ بعد التسبيح بالمعنى المعروف في التعقيب وعمدة مورد التسبيح(١) بالمعنى المشهور إنّما هي التعقيب لا استحباب للتسبيح بالمعنى الثاني.
وبعد هذا أقول : إنّه روى في كامل الزيارة بسنده عن أبي سعيد المدائني ، قال : «دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت : جُعِلتُ فداك ، آتي قبر الحسين عليه السلام
قال :نعم ـ يا أبا سعيد ـ ائت قبر الحسين ابن رسول الله صلى الله عليه وآله أطيب الطيّبين ، وأطهر الطاهرين ، وأبرّ الأبرار ، وإذا زرته يا أبا سعيد فسبّح عند رأسه تسبيح أمير المؤمنين عليه السلام ألف مرة ، وسبّح عند رجليه تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام ألف مرّة ،
__________________
(١) قوله : «وعمدة مورد التسبيح» إشارة إلى استحبابه عند المنام ، كما هو مقتضى غير واحد من الأخبار
ثمّصلّ عنده ركعتين تقرأ فيهما يس والرحمن ، فإذا فعلت ذلك كتب الله لك ثواب ذلك إن شاء الله.
قال : قلت : جُعلت فداك ، علّمني تسبيح عليّ وفاطمة صلوات الله عليهما.
قال :نعم ـ يا أبا سعيد ـ تسبيح عليّ عليه السلام : سبحان الذي لا تنفذ خزائنه ، سبحان الذي لا تبيد معالمه ، سبحان الذي لا ينفد ما عنده ، سبحان الذي لا يشرك أحداً في حكمه ، سبحان الذي لا اضمحلال لفخره ، سبحان الذي لا انقطاع لمدّته ، سبحان الذي لا إلا غيره ،
تسبيح فاطمه عليها السلام : سبحان ذي الجلال الباذخ العظيم ، سبحان ذي العز الشامخ المنيف ، سبحان ذي الملك الفاخر القديم ، سبحان ذي البهجة والجمال ، سبحان من تردى بالنور والوقار ، سبحان من يرى أثر النمل في الصّفاء ووقع الطير في الهواء» (١) .
وفيما رواه في كامل الزيارة أيضاً برواية طويلة بسنده عن الثمالي ، عن أبي عبدالله ...:«ثم تسبّح عند رأسه ألف تسبيحة من تسبيح أمير المؤمنين عليه السلام معالمه ، سبحان من لا ينقص خزائنه ، سبحان من لا انقطاع لمدّته ، سبحان من لا ينفذُ ما عنده ، سبحان من لا اضمحلال لفخره ، سبحان من لا يشاور أحداً في أمره ، سبحان من لا إلـٰه غيره.
ثم قال :وتسبّح عند رجليه ألف تسبيحة من تسبيح فاطمة صلوات الله عليها ، فإن لم تقدر فمائة تسبيحة ، وتقول : سبحان ذي العزّ الشامخ المنيف ، سبحان ذي الجلال الفاخر العظيم ، سبحان ذي الملك الفاخر القديم ، سبحان ذي الملك الفاخر العظيم ، سبحان من لبس العزّة والجمال ، سبحان من تردى بالنور والوقار ، سبحان من يرى أثر
__________________
(١) كامل الزيارة : ٣٨٤ ، الباب ٧٩ باب الزيارات ، الحديث ١٥.
النّمل في الصّفا وخفقان الطير في الهواء ، سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره »(١) .
وفي بعض الأخبار : «ثمّ تصلّي أربع ركعات ، فإذا فرغت وسبّحت تسبيح الزهراء عليها السلام »(٢) .
وفي آخر : «وصل صلاة الزيارة ، وقل بعدها تسبيح الزهراء عليها السلام ».
وفي ثالث : «فتصلّي أربع ركعات ، إلى أن قال : ثم تسبّح تسبيح الزهراء عليها السلام »(٣) .
وفي رابع : «ثمّ صلّ ستّ ركعات ، وسبّح تسبيحة الزهراء عليها السلام »(٤) .
وفي خامس : «وصلِّ ركعتين ، فإذا سلّمت سبّحت تسبيح الزهراء عليها السلام »(٥) .(٦)
وبما سمعت ظهر لك اختلاف الروايتين الأوليين في تسبيح عليّ عليه السلام ، وكذا في تسبيح فاطمة سلام الله عليها.
وإن ما ذكره السيّد الداماد في تسبيح فاطمة سلام الله عليها بالمعنى الثاني يُطابق الرّواية الأولى.
__________________
(١) كامل الزيارة : ٣٩٣ ، الباب ٧٩ باب الزيارات ، الحديث ٢٣.
(٢) الظاهر أنّ مراده ما نقله في بحار الأنوار عن مصباح السيّد ابن طاووس ، فراجع بحار الأنوار : ٩٧: ٤١٣
(٣) الظاهر أنّه إشارة لما ذكره الشيخ في مصباح المتهجّد : ٧٥٤.
(٤) الظاهر أنّه إشارة لما ذكره العلّامة المجلسي في بحار الأنوار ، وتقدّمت الإشارة إليه في : ٩٧: ٢٨٨.
(٥) الظاهر أنّه إشارة لما ذكره الشيخ في مصباح المتهجّد : ١٤٧.
(٦) وفي بعض أخبار الزيارة بالنيابة : «ثمّ ادع لنفسك بما أحببت ، ثمّ مل إلى القبلة وسبّح تسبيح الزهراء عليها السلام ». منه رحمه الله.
[التنبيه] الخامس :
في أن زيارة عاشوراء تختصّ بالبعيد أو تعمّ القريب؟
إنّ الزيارة المبحوث عنها تختصّ بالبعيد أو تعمّ القريب
وربّما يظهر الأوّل من العلّامة المجلسي قدس سره في «تحفة الزائر» و «زاد المعاد» على ما تقدّم الكلام فيه.
أقول : إن مقتضى صدر رواية كامل الزيارة سؤالاً وجواباً ، حيث قال مالك الجهني : جُعلت فداك ، فما لمن كان في بعيد البلاد وأقاصيها ولم يمكنه المصير إليه في ذلك اليوم؟
فقال أبو عبد الله عليه السلام :إذا كان ذلك اليوم برز إلى الصحراء ، أو صعد سطحاً مرتفعاً في داره ، وأومأ إليه بالسلام ، واجتهد على قاتله بالدّعاء ، وصلّى بعده ركعتين ، هو اختصاص الزيارة المذكورة بالبعيد ، أمّا السؤال فظاهر الحال ، وأمّا الجواب فلاشتراط البروز إلى الصحراء والصعود إلى سطح الدار والإيماء ، لظهور كل من هذه الشرائط في البعيد.
إلّا أن يقال : إنّ اشتراط البروز والصعود وإن كان ظاهراً في البعيد ، لكن اشتراط الإيماء غير ظاهر في ذلك ، إذ المقصود بالإيماء بالسلام هو توجيه السلام ، وهذا أعم من البعيد ، وعلى ذلك المنوال الحال في صدر رواية «المصباح» ، حيث قال عقبة : جُعلت فداك ، فما لمن كان في بعيد البلاد وأقاصيها ولم يمكنه المسير إليه في ذلك اليوم؟
فقال أبو جعفر عليه السلام :إذا كان كذلك برز إلى الصحراء ، أو صعد مرتفعاً في داره ، وأومأ إليه بالسّلام ، واجتهد في الدعاء ، وصلّى من بعد ركعتين ، فإنّ مقتضاه أيضاً
سؤالاً وجواباً اختصاص الزيارة المذكورة بالبعيد على ما يظهر ممّا سمعت ، وهو مقتضى ما في آخر رواية علقمة حيث قال أبو جعفر عليه السلام :يا علقمة ، إن استطعت أن تزوره في كل يوم بهذه الزيارة من دارك فافعل.
إلّا أنّه إنّما يتّجه على ما رواه في «المصباح» ، لكن في كامل الزيارة مكان «دارك» «دهرك» ، ولا دلالة فيه على الاختصاص والعموم رأساً ، ومقتضى صريح رواية علقمة سؤالاً وجواباً ، حيث قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : علّمني دعاء أدعو به في ذلك اليوم إذا أنا زرته من قرب ، ودعاء أدعو به إذا أنا لم أزره من قرب ، وأومأت من بعد البلاد ومن داري إليه بالسّلام عليه؟
فقال لي : يا علقمة ،إذا أنت صلّيت الركعتين بعد أن تومئ إليه بالسّلام فقل عند الإيماء إليه من بعد التكبير ، هو عموم الزيارة المذكورة للقريب والبعيد.
إلّا أن يقال : إن السؤال فيه وإن كان أعمّ من القريب والبعيد ، لكن الجواب ظاهر في القريب قضية الإيماء.
لكنه مدفوع : بما سمعت من أنّ المقصود بالإيماء بالسّلام هو توجيه السلام ولا دلالة فيه على اختصاص الزيارة بالبعيد ، مضافاً إلى أن الظاهر تطابق الجواب مع السؤال ، ومن البعيد كون الجواب أخصّ من السؤال وهو أعني العموم مقتضى ما رواه صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام في رواية «المصباح» ومحمّد بن المشهدي من قوله عليه السلام :فإنّي ضامن على الله لكلّ من زار بهذه الزيارة ، ودعا بهذا الدعاء من قرب أو بعد ؛ بناء على كون المقصود هو زيارة عاشوراء لا الأعمّ منها ومن زيارة أمير المؤمنين عليه السلام ، كما هو الحال في قوله عليه السلام في رواية محمّد بن المشهدي :وزرهما بهذه الزيارة ، وقوله عليه السلام :فإنّي ضامن على الله لكلّ من زارهما بهذه الزيارة ، وعلى ذلك المنوال قوله عليه السلام في رواية «المصباح» ومحمّد بن المشهدي :وقد آلى الله عزّ وجلّ على نفسه أنّ من زار الحسين عليه السلام بهذه الزيارة من قرب أو بعد؟
لكن نقول : إنّ التصرّف فيما دلّ على زيارة البعيد بعدم الاختصاص بعدم المفهوم أولى من ارتكاب التقييد فيما دلّ على العموم للقريب ، فالبناء على العموم أقرب.
وإن قلت : إنّ التقييد أمر سهل بل هو أشيع من التخصيص.
قلت : إنّ التقييد إنّما يتأتى لو كان المطلق من باب اسم الجنس أو النكرة ، وأما لو كان من باب التصريح بالعموم للفردين فالأمر من باب التعارض بالتباين ، نظير أنّه لو قيل : «أكرم زيداً وعمرواً» ، ثمّ قيل : «لا تكرم زيداً» يكون التعارض من باب التباين لا العموم والخصوص بالعموم والخصوص الأصولي ، كما توهّمه بعضٌ ، وقد حرّرنا الكلام فيه في الأصول.
[التنبيه] السادس :
في أنه هل يشترط في زيارة عاشوراء من البعيد بالبروز
إلى الصحراء أو الصعود فوق الدار أو لا؟
إنّ مقتضى ما تقدّم من صدر رواية كامل الزيارة وصدر رواية «المصباح» أنه يشترط للبعيد أن يبرز إلى الصحراء أو يصعد إلى فوق الدار ، حيث قال في الأوّل(١) : «قلت : جعلت فداك ، فما لمن كان في بعيد البلاد وأقاصيها ولم يمكنه المسير إليه في ذلك اليوم؟
قال :إذا كان ذلك اليوم برز إلى الصحراء أو صعد سطحاً مرتفعاً في داره الخ»
وقال في الثاني(٢) :
«قلت : جعلت فداك ، فما لمن كان في بعد البلاد وأقاصيها ولم يمكنه المسير إليه في ذلك اليوم؟
قال :إذا كان كذلك برز إلى الصحراء أو صعد سطحاً مرفتعاً في داره » ، لكن مقتضى قول علقمة : «ومن سطح داري» في سؤاله عن أبي جعفر عليه السلام بقوله : «علّمني دعاء أدعو به في ذلك اليوم إذا أنا زرته من قريب ، ودعاء أدعو به إذا لم أزره من قريب وأومأت إليه من بعد البلاد ومن سطح داري؟» في رواية كامل الزيارة هو تعاهد اشتراط خصوص الصّعود فوق الدار.
لكن في رواية «المصباح» : «ومن داري» فالعطف على «بعد البلاد» من باب العطف التفسيري ، إلّا أن الزيارة مقدّمة على النقيصة ، لكون النقيصة أقرب إلى
__________________
(١) يعني صدر كامل الزيارة.
(٢) يعني صدر رواية المصباح.
الاشتباه ، ومقتضى غير واحد من أخبار الاشتراط ، خصوص الصّعود إلى فوق الدار.
إما في باب مطلق الزيارة ، كما في «الكافي» و «التهذيب» بالإسناد عن ابن أبي عمير ، عمّن رواه ، قال : «قال أبو عبد الله عليه السلام :إذا بعدت بأحدكم الشقّة (١) ونأت به الدار ، فليَعْلُ أعلى منزله ، وليصلّ ركعتين ، وليومِ بالسّلام إلى قبورنا ، فإنّ ذلك يصل إلينا »(٢) .
وما في «الفقيه» مرسلاً : عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، قال : «قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا بعدت لأحدكم الشقّة ونأت به الدار ، فليصعد على منزله ، وليصلِّ ركعتين ، وليومِ بالسلام إلى قبورنا ، فإنّ ذلك يصل إلينا »(٣) .
وأما ما في زيارة سيّد الشهداء عليه السلام(٤) ، كما في «الفقيه» مرسلاً : عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، قال : «قال أبو عبد الله عليه السلام : يا سدير(٥) ، تزور قبر الحسين عليه السلام في كلّ يوم؟
قلت : جعلت فداك ، لا إلى أن قال :فتزوره في كلّ سنة؟
قلت : قد يكون ذلك.
قال : ياسدير ،ما أجفاكم (٦) للحسين عليه السلام، أما علمت أنّ لله تبارك وتعالى ألف
__________________
(١) الشقّة ـ بالضم والكسر ـ : البعد والناحية ، ذكره في القاموس. منه عفي عنه.
(٢) فروع الكافي : ٤: ٥٨٧ ، باب النوادر ، الحديث ١. وفي التهذيب : ٦: ١٠٣ ، باب من بعدت شقّته وتعذّر عليه قصد المشاهد ، الحديث ١.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ٢: ٥٩٩ ، باب ما يقوم مقام زيارة الحسين عليه السلام وغيره ، الحديث ١.
(٤) قوله : «وأمّا في باب زيارة سيّد الشهداء عليه السلام» ظاهر غير واحد من زيارات سيّد الشهداء عليه السلام المرويّة في كامل الزيارة اشتراط الصعود. منه رحمه الله.
(٥) قوله : «سدير» بفتح السين المهملة. منه عفي عنه.
(٦) قوله : «ما أجفاكم» فعل التعجّب من الجفاء ، أي ما أكثر جفائكم. منه رحمه الله.
ألف ملك شعث (١) غبر يبكون ويزورون ولا يفترون (٢) ، وما عليك ـ يا سدير ـ أن تزور قبر الحسين عليه السلام في كلّ جمعة خمس مرات ، أو في كلّ يوم مرّة.
فقلت : جعلت فداك ، بيننا وبينه فراسخ كثيرة.
فقال :اصعد فوق سطحك ، ثمّ التفت يمنة ويسرة (٣) ،ثمّ ارفع رأسك إلى السماء ، ثمّ تنحو نحو قبر الحسين فتقول : السلام عليك يا أبا عبد الله ، السلام عليك ورحمة الله وبركاته ، يكتب لك بذلك زورة ، والزورة حجّة وعمرة (٤) .
قال سدير : فربّما فعلت ذلك في شهر أكثر من عشرين مرّة».
لكن نقول : إنّه يمكن تقييد مرسل ابن أبي عمير ومرسل الفقيه عن ابن أبي عمير بعد اعتبار السند ، وكلّ منهما أعمّ من زيارة سيّد الشهداء عليه السلام بصدر رواية كامل الزيارة وصدر رواية «المصباح» بعد اعتبار سند الروايتين ، لاختصاصهما بزيارة سيّد الشهداء عليه السلام يوم عاشوراء ، وكذا تقييد خبر سدير بعد اعتبار سنده وإن اختصّ بزيارة سيّد الشهداء عليه السلام بالصدرين المذكورين ، لاختصاصهما بزيارة سيّد الشهداء عليه السلام يوم عاشوراء.
__________________
(١) وقوله : «شعث». الشعث ـ محرّكة ـ: انتشار الأمر ، ومصدر الأشعث للمغبرّ الرأس ، كما في القاموس. منه رحمه الله.
(٢) قوله : «لا يفترون». قال في القاموس : «فتر يفتُرُ ويفتِرُ سكن بعد حدّة ولان بعد شدّة». منه رحمه الله.
(٣) قوله : «يمنة ويسرة» بفتح الياء وسكون الميم والسين على ما اُعرب في الصحاح. قال : اليمنة : خلاف اليسرة ، وقال : قعد فلان يمنة.
وفي بحار الأنوار : «لا يبعد أن يكون الالتفات يمنة ويسرة وإلى جانب الفوق للتقيّة لئلّا يطلع عليه أحد». منه عفي عنه.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ٢:٥٩٩ ، باب ما يقوم مقام زيارة الحسين عليه السلام وزيارة غيره ، الحديث ٢.
ويمكن أن يقال : إن مقتضى قوله عليه السلام : «إذا أنت صلّيت الركعتين بعد أن تومئ إليه بالسّلام وقلت عند الإيماء إليه بعد الركعتين هذا القول» في ذيل رواية كامل الزيارة.
وكذا قوله عليه السلام : «وإذا أنت صلّيت الركعتين بعد أن تومئ إليه بالسلام ، فقل عند الإيماء إليه بعد التكبير هذا القول » في ذيل رواية «المصباح» ، عدم اشتراط البروز إلى الصحراء والصعود فوق سطح الدار.
إلّا أن يقال : إنّ قوله عليه السلام : «تومئ إليه بالسلام » في ذيل الروايتين إيماء إلى قوله عليه السلام : «وأومئ إليه بالسلام » في صدر الروايتين المسبوق باشتراط البروز والصعود ، مع أن التقييد أمر سهل بعد اعتبار سند المطلق والمقيّد.
ويمكن أن يقال : إن مقتضى قول الصادق عليه السلام في آخر رواية صفوان : «إذا حدث لك إلى الله حاجة فزر بهذه الزيارة » هو عدم اشتراط البروز والصعود.
إلّا أن يقال : إنّ الظاهر أنّ الغرض من قوله عليه السلام : «من حيث كنت » هو عدم الحاجة إلى المسافرة والزيارة عن قرب ، مضافاً إلى سهولة التقييد ، إذ لا يخرج أمر قوله عليه السلام : «من حيث كنت » عن الإطلاق.
تذييلات
أحدها : في أنّه لو كان سطوح الدار مختلفة فكان بعضها فوق بعض ،
فهل المدار تعييناً أو تخييراً على الأرفع أو يكفي المرتفع؟
الأظهر الأخير ، لأنّ مقتضى قوله عليه السلام في صدر رواية كامل الزيارة : «أو صعد سطحاً مرتفعاً في داره » ، وقوله عليه السلام في رواية «المصباح» : «أو صعد مرتفعاً في داره » ، وقوله عليه السلام في خبر حنان بن سدير : «أصعد فوق سطحك »(١) ، كفاية المرتفع.
__________________
(١) المتقدّم ذكره عن الفقيه مرسلاً.
وإن قلت : إن مقتضى قوله عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير ، كما في «الكافي» و «التهذيب» والمرسل عن ابن أبي عمير كما في «الفقيه» : «فليعل أعلى منزله»(١) كون المدار على الأرفع.
قلت :
إنّ الظاهر كون الأعلى من باب الأفعل الوصفي ، فالغرض بالفارسية
(بالاى منزلش) لا من باب أفعل التفضيل بأن يكون الغرض بالفارسية (بالاتر منزلش)
(٢)
. مع أن سائر الروايات يرجّح كون الأمر من باب الأفعل الوصفي.
لكن نقول : إنّ في «الوافي» في مرسل ابن أبي عمير : «فليعل أعلى منزل له »(٣) مقتضاه كون المدار على الأرفع ، بل في رواية حنان بن سدير التي رواها في «كامل الزيارة» : «واصعد إلى أعلى منزل في دارك »(٤) ، بل في رواية أخرى رواها في «كامل الزيارة» أيضاً : «فليعل أعلى منزل له »(٥) .
ثانيها : في أن حكم الدار جار في غير الدار ، سواء كان المدار على المرتفع أو الأرفع
إنّ حكم الدار جار في غير الدار ، كالمدرسة والمسجد ، سواء كان المدار على المرتفع أو الأرفع ، للقطع بعدم الفرق ، بل التعبير بالدار في رواية «كامل الزيارة»
__________________
(١) المتقدّم ذكرها.
(٢) قوله : «بالاتر منزلش» يمكن أن يقرأ بكسر الراء وسكونها. منه رحمه الله.
(٣) الوافي : ١٤ : ١٥٧٧ ، باب زيارتهم عليهم السلام من بعيد ، الحديث ١٤٦٥٥/١ ، حيث نقل مرسلة ابن أبي عمير المتقدّم ذكرها عن الكافي والتهذيب ، بهذه العبارة : «فليعل أعلى منزل له» بينما المذكور فيما تقدّم عن الكافي والتهذيب : «فليعل أعلى منزله».
(٤) كامل الزيارة : ٤٨٣ ، باب ٩٦ من نأت داره وبعدت شقّته كيف يزوره عليه السلام ، الحديث ٧ ، ولكن فيه : «واصعد أعلى موضع في دارك».
(٥) كامل الزيارة : ٤٨٠ ، باب ٩٦ من نأت داره وبعدت شقّته كيف يزوره عليه السلام ، الحديث ١.
و ««المصباح» وارد مورد الغالب ، مضافاً إلى أنّ المأخوذ في مرسل ابن أبي عمير والمرسل عن ابن أبي عمير هو أعلى المنزل والمنزل أعمّ من الدار.
ثالثها : في أنّه لو كان البعيد في أحد المشاهد المشرّفة ، فهل يطرد اشتراط البروز والصعود بناءً على الاشتراط أم لا؟
إنّه لو كان البعيد في أحد المشاهد المشرّفة على مشرفيها آلاف السّلام والتحيّة ، فهل يطرد اشتراط البروز والصّعود ، بناء على الاشتراط أم لا؟
أقول : إنّه إن كان البعيد في حرم أمير المؤمنين عليه السلام فمقتضى فعل صفوان المحكي عن الصادق عليه السلام ، حيث زار سيّد الشهداء عليه السلام في حرم أمير المؤمنين عليه السلام عدم اطراد الاشتراط ، قضية قول سيف بن عميرة : «فزرنا أمير المؤمنين عليه السلام ، فلمّا فرغنا من زيارته صرف صفوان وجهه إلى ناحية أبي عبد الله عليه السلام ، فقال :تزورون الحسين عليه السلام » ، بل اشتراط البروز والصّعود في صدر رواية «كامل الزيارة» و ««المصباح»» ينصرف إلى الأمكنة المتعارفة الغالبة ولا يشمل الحرم المحترم المذكور ، فيقيد إطلاق الاشتراط بعد شموله للحرم المحترم المذكور بفعل الصادق عليه السلام بعد اعتبار سند المطلق والمقيد ، بل الاعتبار يقضي أيضاً بالتقييد لكمال شرافة الحرم المحترم المذكور.
وبما ذكرنا من انصراف إطلاق الاشتراط إلى الأمكنة المتعارفة ، مضافاً إلى الاعتبار ، يتّجه القول بجواز الزيارة من سائر المشاهد المشرّفة.
ويمكن أن يقال : إن حديث الانصراف لا يثبت كفاية الزيارة من المشاهد المشرّفة ، إذ لا مفهوم للإنصراف ، وإن يقتضي بعض كلمات المحقّق القمّي ثبوت المفهوم لانصراف المطلق إلى الفرد الشائع في باب الفرد النادر ، فالأمر في الزيارة من المشاهد المشرّفة مشكوك فيه فلابدّ من الرجوع إلى مقام العمل والبناء على
الاشتراط على القول بالاحتياط في باب الشكّ في المكلّف به ، والقول بعدم الاشتراط على القول بحكومة أصل البرائة ، إلّا أنه ها هنا لا يجري أصالة البراءة بناء على عدم جريانها في المستحبات ، كما هو الأظهر ، وإنما تجري أصالة العدم ، لو قلنا بحجيّتها ، وإلّا فلابدّ من البناء على الاشتراط ، عملاً باستصحاب عدم الإتيان بالزيارة المندوبة ، بل على القول بالاحتياط في الشكّ في المكلّف به ، لا تجري هنا قاعدة الإشتغال ، ومدرك القول بالاشتراط هنا على القول المذكور منحصر أيضاً في استصحاب عدم الإتيان بالمستحب ، والأمر في المقام نظير الغُلْيان في الصوم المندوب ، وقد حرّرنا الكلام فيه في رسالة منفردة
ويمكن أن يقال : إنه بعد فرض انصراف الاشتراط إلى غير المشاهد المشرّفة ، فمقتضى كون المتكلّم في مقام البيان واطلاعه على الإنصراف عدم اطّراد الاشتراط في المشاهد المشرّفة فلا يتجاوز الكلام في المقام عن مقام الاجتهاد.
لكن يمكن القول : بأن المفروض انحصار الدليل على الاشتراط فلما فرض الانصراف يحصل الظن بعدم اطراد اشتراط البروز والصعود في المشاهد المشرّفة ، لعدم الدليل على الاطراد.
إلّا أن يقال : إنّه يتبني حجيّة هذا الظن بعد فرض حصوله على حجيّة مطلق الظنّ.
إلّا أن يقال : إنّه يتأتّى الحجيّة ، ولو على القول بحجيّة الظنون الخاصّة ، بناء على حجيّة الظنّ الناشئ من اللفظ ولو بالواسطة ولو على القول بحجيّة الظنون الخاصّة ، على ما حرّرناه في الاُصول.
إلّا أنّه يشكل : بلزومُ حجيّة القياس لو كان ثبوت الحكم في الأصل باللفظ ، لكون الظن اللفظي الناشئ بالحكم في الفرع ناشئاً من اللفظ بتوسط العقل.
رابعها : فيما يمكن أن يكون حكمة اشتراط البروز والصعود.
إنّه يمكن أن يكون حكمة اشتراط البروز والصعود هي وقوع الزيارة في مكان خلوة خال عن الشواغل الموجبة لتفرق الخيال ، كما هو الحال في أكثر الأحوال والمانعة عن تمحيض القصد وفراغة البال ، كما يشرد إليه ما في زيارة أخرى رواها في «المصباح» مرسلاً عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام من قوله : «تحلل إزرارك ، ثمّ تحسر عن ذراعيك كهيئة أصحاب المصائب ، ثمّ تخرج إلى أرض مقفرة ، أو مكان لا يراك به أحد ، أو تعمد إلى منزل لك خال ، أو في خلوة ، حين يرتفع النهار فتصلّي أربع ركعات؟ إلى أن قال : ثمّ تسلّم وتحوّل وجهك نحو قبر الحسين عليه السلام »(١) .
خامسها : في كلام من الشهيد في «الدروس».
أنه قد حكم الشهيد في «الدروس» باستحباب زيارة النبيّ صلى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام كلّ يوم جمعة ولو من البعد ، وإذا كان على مكان عالٍ كان أفضل(٢) .
وحكم في ««البحار»» بأن ما ذكره من جواز الزيارة في أيّ مكانٍ تيسّر وإن لم يكن موضعاً عالياً لايخلو عن قوة ، تعليلاً بعمومات بعض الأخبار ، قال : «وإن كان الأفضل والأحوط إيقاعها في سطح دار عالٍ أو صحراء»(٣) .
أقول : إنّه إن كان المقصود اقتضاء بعض الأخبار استحباب زيارة النبيّ صلى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام من دون اشتراط الصعود إلى سطح الدار والبروز إلى الصحراء ، وهذا هو المناسب لما ادّعاه الشهيد في «الدروس» ، ففيه بعد اعتبار سند الخبر المذكور
__________________
(١) مصباح المتهجّد : ٧٨٢.
(٢) الدروس : ٢: ١٦ ، باب المزار.
(٣) بحار الأنوار : ٩٨: ٣٧١ ، ذكر ذلك في ذيل الحديث ١٤ من باب زيارة الحسين عليه السلام وسائر الأئمّة عليهم السلام حيّهم وميّتهم من بعيد.
ورود التقييد في زيارة عاشوراء وغيرها كما تقدم ، وإن كان المقصود تعدّد ما يقتضي استحباب عموم الزيارة أو بعض الزيارات من دون الاشتراط بالصعود والبروز ، كما يرشد إليه التعبير بالعمومات ، فإن كان المقصود تعدّد ما يقتضي استحباب بعض الزيارات على الاطلاق فهو لا يناسب مقالة الشهيد ، وإن كان المقصود تعدّد مايقتضي استحباب بعض الزيارات على الاطلاق إلى زيارة النبيّ صلى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام فكون تعدّد المطلق بحيث يوجب الظنّ بالاطلاق ، فهو غير ثابت ، بل الظاهر عدمه ، بل لا إشكال فيه.
[التنبيه] السّابع :
في اشتراط كون زيارة عاشوراء صدر النهار قبل زوال الشمس
أنّ مقتضى رواية كامل الزيارة و «المصباح» كون الزيارة المبحوث عنها صدر النهار قبل زوال الشمس.
أقول : أن المقصود بصدر النهار إما أوّله أو النصف الأوّل.
وعلى الثاني إمّا أن يكون المقصود الأعم بالقبل من القريب والبعيد ، فيعمّ أول النهار على حسب عموم النصف الأوّل ، فالأمر من باب التوضيح.
وإما أن يكون المقصود خصوص القبل القريب ، فالأمر من باب التخصيص.
وعلى الأوّل يتعيّن كون المقصود بالقبل هو القبل البعيد ، لكن لا إشكال في كون الوجه الأوّل خلاف الظاهر ، والوجه الثاني أيضاً خلاف الظاهر ، فيتعيّن الوجه الأخير أعني كون المقصود بالصدر هو النصف الأوّل والمقصود بالقبل هو القبل القريب.
وإن قلت : إن الظاهر من الصدر هو الأوّل ، والحمل على النصّف الأوّل خلاف الظاهر ، والظاهر من القبل هو القبل القريب ، والحمل على القبل البعيد والأعمّ خلاف الظاهر ، ولاترجيح لحمل القبل على القبل القريب ، وحمل الصدر على النصف الأوّل على حمل القبل على القبل البعيد أو الأعم وحمل الصدر على الأوّل.
قلت : إن المرجّح هو العرف وفيه الكفاية ، كيف لا وفي جميع موارد التجوّز مع القرينة يدور الأمر بين التصرّف في المقرون والتصرّف في القرينة ، والمرجّح العرف(١) ، مثلاً في (رأيت أسداً يرمي) يدور الأمر بين حمل الأسد على الرجل
__________________
(١) قوله : «والمرجّح العرف» ويتأتّى الترجيح بالعليّة أيضاً بالبناء على المجاز فيما كان»
الشجاع ، وحمل الرّمي في يرمي على معناه الحقيقي ، وحمل الأسد على الحيوان المفترس ، وحمل الرمي على إثارة التراب ، وكذا الحال في (رأيت أسداً في الحمام) حيث إن الأمر دائر بين حمل الأسد على الرجل الشجاع ، وحمل الحمام على معناه الحقيقي ، وحمل الأسد على الحيوان المفترس ، وحمل الحمام على الفلاة الحارة ، وليس حمل الأسد على الرجل الشجاع في المثالين كما هو المعروف ، بل السائر مسير المثل إلّا من باب الترجيح بالعرف ، ونظيره ما قيل في باب تعارض الأمر بالشيء مع النهيّ عنه بالجمع بحمل الأمر على الرخصة في الفعل ، والنهي على الكراهة ، مع إمكان الجمع بالعكس أعني حمل النهي على الرخصة في الترك وحمل الأمر على الاستحباب ، من أن المرجّح هو العرف ، مع قطع النظر عن غلبة استعمال الأمر في الرخصة بالنسبة إلى استعمال النهي في الرخصة ، هذا وعلى تقدير حمل الصّدر على الأوّل والقبل على القبل البعيد يختلف الأوّل باختلاف معنى النهار ، فعلى القول بكون ابتداء النهار من أول طلوع الفجر ، فأوّل النهار هو ما بين الطّلوعين ، وعلى القول بكون ابتدائه لغة أو بحسب الحقيقة الشرعية من أوّل طلوع الشمس على القولين في المقام ، فأوّل النهار هو أوّل طلوع الشمس.
لكن يمكن القول : بانصراف النهار إلى بعض الأجزاء مع اختلاف الانصراف والمنصرف إليه نظير انصراف الكلي إلى الجزئي من باب انصراف المطلق إلى بعض الأفراد من جهة شيوع الفرد أو غيره ، والظاهر من النهار هنا هو ما بين طلوع الشمس وغروبها ، أو ذهاب الحمرة ، والظاهر من النهار في استيجار شخص لتنظيف حريم
__________________
«التجوّز فيه من القرينة أو المقرون أغلب. هذا ، ونظير دوران الأمر بين ارتكاب خلاف الظاهر على وجه الحقيقة في القرينة والمقرون ، فلا بدّ من البناء على العرف وارتكاب خلاف الظاهر فيما كان وقوع أحد خلاف الظاهر فيه أغلب. منه رحمه الله.
الباب هو القدر الوافي بالتنظيف مما بعد طلوع الشمس ، لكن الظاهر من النهار في استيجار شخص لخدمة حمّام الرجال هو ما بين طلوعُ الفجر وغروب الشمس أو ذهاب الحمرة ، بل الظاهر دخول قليل مما قبل الطلوع وبعد الغروب.
إلّا أن يقال : إنّ النهار في موارد الإنصراف إلى الجزء مستعمل في معناه الحققي ، أعني ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس ، أو ذهاب الحمرة ، بناء على ما هو المفروض من كون ابتداء النهار من طلوع الفجر.
إلا أن الحكم الوارد على الكل أعني النهار يختلف انصراف وروده على الأجزاء ، وليس هذا من باب استعمال الكل في الجزء ، بل صدق ورود الحكم الوارد على الكلّ بوروده على الجزء واختلاف انصراف ورود الحكم واختلاف مورد الحكم على حسب اختلاف ورود الحكم في الموارد ، مثلاً لو قال بعض الخدّام (جلست في الدار) فالدار مُستعمل في معناه الحقيقي ، لكن الظاهر كون الجلوس في الدّهليز ، وأما لو قال بعض الموالي (جلست في الدار) فالدار مستعمل أيضاً في معناه الحقيقي ، لكن الظاهر كون الجلوس في البيت.
لكن نقول : إن ما ذكر وإن كان الظاهر تماميته ، لكن لا يتمّ في صدر النهار بناء على ما ادّعينا من ظهور كون النهار حقيقة في ما بين طلوع الشمس وغروبها أو ذهاب الحمرة.
وينبغي أن يعلم أنه يتأتى الكلام في أنّ منتهى النهار هو استتار القرص ، أو ذهاب الحمرة المشرقية ، بناء على انفكاك ذهاب الحمرة عن الاستتار ، وإلّا فالنمتهى هو ذهاب الحمرة.
وأيضاً يتأتى الكلام في اليوم بداية ونهاية على حسب الكلام في النهار لو قلنا بترادف اليوم والنهار ، وإلّا فيختلف الكلام.
[التنبيه] الثامن :
في أنّه هل يشترط زيارة عاشوراء بالغُسل؟
أنه هل يشترط الزيارة المتقدّمة بالغسل؟
ربّما يقال لا إشكال في استحباب الغسل لعموم ما دل على استحبابه في مطلق الزيارة.
أقول : إنّ مقتضى خلوّ رواية كامل الزيارة و «المصباح» من اشتراط الغسل وكذا خلو فعل صفوان عن الغسل ، عدم اشتراط تلك الزيارة بالغسل.
بل نقول : إنّ في طائفة مما رواه في كامل الزيارة التصريح بعدم اشتراط الغسل في زيارة سيّد الشهداء.
كما رواه بسنده عن الحسن بن عطية ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغسل إذا أتيت قبر الحسين عليه السلام؟
قال :ليس عليك غسل »(١) .
وما رواه أيضاً بسنده عن أبي اليسع ، قال : «سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن الغسل إذا أتى قبر الحسين عليه السلام.
فقال :لا »(٢) .
إلّا أن يقال : إنّ المقصود عدم اشتراط الغسل في مُجرّد التشرف بالإتيان إلى قبر سيّد الشهداء عليه السلام.
__________________
(١) كامل الزيارة : ٣٤٨ ، الباب ٧٦ الرخصة في ترك الغسل لزيارة الحسين عليه السلام ، الحديث ٩.
(٢) كامل الزيارة : ٣٤٧ ، الباب ٧٦ الرخصة في ترك الغسل لزيارة الحسين عليه السلام ، الحديث ٤.
إلّا أن يقال : إنّ الظاهر الإتيان للزيارة ، كما هو صريح الخبر الأخير ، بل الظاهر أنّ الإتيان بدون الزيارة نادر ، بل معدوم.
لكن نقول : إن مقتضى طائفة أخرى مما رواه في كامل الزيارة اشتراط الغسل.
كما رواه فيه بسنده عن علي بن جعفر الهمْداني ، عن العسكري عليه السلام قال : «من خرج من بيته يريد زيارة الحُسين بن عليّ عليهما السلام فصار إلى الفرات فاغتسل منه كُتِبَ من المفلحين ، فإذا سلم على أبي عبد الله عليه السلام كتب من الفائزين ، فإذا فرغ من صلاته أتاه ملك فقال له : إن رسول الله صلى الله عليه وآله يقرئك السّلام ويقول لك : أما إن ذنوبك فقد غُفِرَت لك ، استانف العمل »(١) .
وما رواه فيه بسنده عن يوسف الكناسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «إذا أتيت قبر الحُسين بن عليّ عليه السلام فأتِ الفرات واغتسل بحيال قبره »(٢) .
وما رواه فيه بسنده عن بشير الدهّان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «ويحك! يا بشير إن المؤمن إذا أتاه عارفاً بحقّه فاغتسل في الفرات كتب له بكلّ خطوة حجّة وعمرة مبرورات متقبّلات وغزوة مع نبيّ مرسل وإمام عدل »(٣) .
وما رواه فيه بسنده عن صفوان الجمّال عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «من اغتسل بماء الفرات وزار قبر الحسين عليه السلام كان كيوم ولدته أمّه »(٤) إلى آخر الحديث.
وهو مقتضى ما رواه في «التهذيب» بسنده : عن الحسن بن عبدالرحمن الرواسي(٥) ، عمّن حدثه ، عن بشير الدّهان ، عن الصادق عليه السلام قال : «من اغتسل في
__________________
(١) كامل الزيارة : ٣٤٤ ، الباب ٧٥ من اغتسل في الفرات وزار الحسين عليه السلام ، الحديث ٥.
(٢) كامل الزيارة : ٣٤٥ ، الباب ٧٥ مَن اغتسل فى الفرات وزار الحسين عليه السلام ، الحديث ٨.
(٣) كامل الزيارة : ٣٤٣ ، الباب ٧٥ مَن اغتسل فى الفرات وزار الحسين عليه السلام ، الحديث ٢.
(٤) كامل الزيارة : ٣٤٢ ، الباب ٧٥ مَن اغتسل فى الفرات وزار الحسين عليه السلام ، الحديث ١.
(٥) قوله : «الرواسي» بضمّ الراء المهملة والسين المهملة ، كما في التوضيح. منه رحمه الله.
الفرات ثم مشى إلى قبر الحسين عليه السلام كان له بكل قدم يرفعها ويضعها حجّة متقبّلة بمناسكها »(١) .
وكذا ما رواه فيه بسنده عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، قال : «كان أبو عبد الله عليه السلام يقول في غسل الزيارة إذا فرغ من الغسل :اللهم اجعل لي »(٢) إلى آخر الدعاء.
إلا أن الاستدلال به بعد اعتبار سنده وثبوت التأسي بالإمام ، كما هو الحقّ كما حررّناه في الأصول خلافاً للمشارق حيث تأمّل فيه(٣) ، مبنيّ على دلالته على المداومة على الغسل ، وإلّا فلايثبت الاشتراط ، وكذا على دلالته على اشتراط الغسل لا كون الأمر من باب المستحب في المستحب ، حيث إنه قد وقع الكلام فيما فعله النبيّ صلى الله عليه وآله في ضمن الواجب في كون الأمر من باب الإناطة بالجزئية أو الشرطية أو الوجوب التعبّدي.
إلا أن الظاهر الاشتراط هنا والإناطة في باب الواجب.
إلا أن اعتبار الظهور مبنيّ على اعتبار نظر الناشئ من الفعل ، ومع هذا يبتني الاستدلال على كون الزيارة زيارة سيّد الشهداء عليه السلام.
__________________
(١) الظاهر أنّ المصنّف هنا سهى قلمه الشريف فركب سند رواية على متن رواية اُخرى ، حيث إنّ الشيخ في التهذيب : ٦: ٥٣ ، ذكر هذا المتن بسنده إلى الحسين بن سعيد ، عن جعفر بن محمّد عليه السلام ، وهو الحديث الرابع في الباب ١٧ ، باب فضل الغسل للزيارة.
وأمّا السند الذي ذكره المصنّف هنا فهو للحديث الأوّل في نفس الباب ، ونذكره لارتباطه بالموضوع : «قال : من أتاه ـ يعني الحسين عليه السلام ـ فتوضّأ واغتسل من الفرات لم يرفع قدماً ولم يضع قدماً إلّاكتب الله بذلك حجّة وعمرة».
(٢) تهذيب الأحكام : ٦: ٤٥ ، الباب ١٧ باب فضل الغسل للزيارة ، الحديث ٧.
(٣) مراده بذلك : مشارق الشموس في شرح الدروس : ١: ٨٨ ، للمحقّق الخوانساري المعروف بين أهل العلم بـ (آقا جمال) ، حيث إنّ المحقّق الخوانساري استشكل في ثبوت التأسّي بالإمام ، وظاهر كلامه اختصاصه بالنبيّ صلى الله عليه وآله.
لكن يمكن أن يذبّ عنه : بأن الشيخ ذكره في باب فضل غسل الزيارة ، وهذا الباب مقعود في غسل زيارة سيّد الشهداء عليه السلام ، وإن كان العنوان مطلقاً ، بشهادة الباب السابق عليه والباب اللاحق له ، حيث إنّ الباب السابق عليه باب نسب أبي عبد الله الحسين بن عليّ عليهما السلام وباب فضل زيارته ، والباب اللاحق له باب زيارته ، والغرض زيارة سيّد الشهداء عليه السلام وباب وداع أبي عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام.
بل نقول : إنّ مقتضى بعض الروايات تعاهد الاشتراط.
كما رواه في كامل الزيارة بسنده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : «أتاه رجل فقال له : هل يزار والدك؟
فقال :نعم إلى قال :من اغتسل من ماء الفرات وهو يريده تساقطت عنه خطا ياهُ كيوم ولدته اُمّه »(١) .
وكذا ما رواه في «كامل الزيارة»(٢) : عن الحسن بن زبرقان(٣) الطبري بإسناده يرفعه إلى الصادق عليه السلام قال : «قلت ربّما أتينا قبر الحسين بن عليّ عليه السلام فيصعب علينا الغسل للزيارة من البرد أو غيره. فقال عليه السلام :من اغتسل في الفرات وزار الحسين عليه السلام كتب له من الفضل ما لا يحصى ...»(٤) .
__________________
(١) كامل الزيارة : ٣٤٤ ، الباب ٧٥ مَن اغتسل في الفرات وزار الحسين عليه السلام ، الحديث ٤.
(٢) قوله : «وكذا ما رواه في كامل الزيارة» هذا ما كتبه سابقاً ، لكنّه بعدما نقل من عبارة الحديث ، فمتى ما رجع إلى الموضع الذي اغتسل فيه وتوضّأ وزار الحسين عليه السلام كتب له ذلك الثواب ، ومقتضاه عدم اشتراط الغسل ، ويرشد إليه أنّ الحديث مذكور في كامل الزيارة في باب الرخصة في ترك الغسل لزيارة الحسين بن عليّ صلوات الله عليه. منه رحمه الله.
(٣) قوله : «زبرقان» بكسر الزاي المعجمّة وسكون الباء الموحدة وكسر اللام المهملة والقاف ، كما في التوضيح. منه عفي عنه.
(٤) كامل الزيارة : ٣٤٨ ، الباب ٧٦ الرخصة في ترك الغسل لزيارة الحسين عليه السلام ، الحديث ١٠.
بل مقتضاه شدة الاهتمام في باب الغسل وعدم ارتفاع اشتراطه بالعسر والحرج.
إلّا أن يقال : إن اعتبار شيء في عبادة ، سواء كان بالأمر الحاضر أو الغائب أو بالجملة الخبريّة ، ظاهر في كون الأمر من باب الاشتراط ، لا الواجب التعبدي في الواجب إن كانت العبادة واجبة ، أو المستحبّ في المستحب إن كانت العبادة مستحبة ، كما أنّ النهي عن الشيء مقيّداً بعبادة ظاهر في كون الأمر من باب الممانعة وفساد العبادة مع الاقتران بالمنهيّ عنه ، والأمر بالشيء مقيّداً بعبادة بالأمر الحاضر غير عزيز ، وقد حرّرنا المقال فيه في الأصول ، ومن باب الأمر الغائب والجملة الخبريّة ما في بيان زيارة عاشوراء من قوله :«فليعل أعلى منزله » ، وقوله عليه السلام : «برز إلى الصحراء أو صعد مرتفعاً في داره » حكاية الصعود إلى السطح والبروز إلى الصحراء في زيارة عاشوراء في الأمر الغائب ومطلق الزيارة في الجملة الخبريّة ، ويظهر الحال بما مرّ ، لكن اعتبار شيء في العبادة على وجه القضية الشرطية ، كما في هذه الأخبار المذكورة لا دلالة فيه على اشتراط الشيء في العبادة ، وإنّما المدلول اشتراط ترتّب الثواب والجزاء بالشيء المذكور ، فغاية الأمر الدلالة على كمال العبادة لا الاشتراط والإناطة.
بل نقول : إنّ مقتضى كثير من الروايات كون الغسل من باب الكمال.
كما رواه في «كامل الزيارة» بسنده عن بشير الدّهان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «من أتى الحسين بن عليّ عليهما السلام فتوضّأ واغتسل في الفرات ، لم يرفع قدماً ولم يضع قدماً إلّا كتب الله عليه حجّة وعمرة »(١) .
إذ لم يقل أحد باشتراط الوضوء مع الغسل لو كان العبارة بالواو ، أو على وجه الترديد لو كانت العبارة بأو ، فالظاهر مساوقة الوضوء والغسل ولا إشكال في كون الوضوء من باب الكمال.
__________________
(١) كامل الزيارة : ٣٤٥ ، الباب ٧٥ مَن اغتسل في الفرات وزار الحسين عليه السلام ، الحديث ٧.
وكذا ما رواه في «كامل الزيارة» بسنده عن يونس بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : «إذا كنت منه قريباً ، يعني الحسين عليه السلام فإن أصبت غسلاً فاغتسل وإلّا فتوضّأ ...»(١) .
إلّا أن يقال : إنّ الأمر فيه ليس على منوال الرواية السابقة ، إذ لا بأس باستحباب الوضوء لمن لم يتمكّن من الغسل.
وكذا ما رواه في «كامل الزيارة» بسنده عن أبي الصّامت ، قال : «سمعت أبا عبد الله عليه السلام وهو يقول :من أتي قبر الحسين عليه السلام ماشياً كتب الله له بكلّ خطوة ألف حسنة ، ومحى عنه ألف سيئة ، ورفع له ألف درجة ، فإذا أتيت الفرات فاغتسل وعلّق نعليك وامشِ حافياً وامشِ مشي العبد الذليل ، فإذا أتيت باب الحائر فكبّر أربعاً ثم امشِ قليلاً ثم كبّر أربعاً ثم ائت رأسه فقف عليه فكبّر أربعاً وصلّ عنده واسأل الله حاجتك »(٢) .
إذ مقتضى الوقوع في سياق تعليق النعل والمشي حافياً ومشى العبد الذليل استحباب الغسل كاستحباب التعليق والمشي حافياً ومشي العبد الذليل.
نعم ظاهر اعتبار التكبير ولاسيّما أربعاً خصوصاً على التفصيل المذكور في الحديث اشتراط التكبير وهو الحال في الصّلاة.
وكذا ما رواه في «كامل الزيارة» بسنده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، وعن نسخة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : «قلت : إذا خرجنا إلى أبيك فلسنا في حج؟
قال :بلى.
قلت : فيلزمنا ما يلزم الحاج؟
__________________
(١) كامل الزيارة : ٣٤٨ ، الباب ٧٦ الرخصة في ترك الغسل لزيارة الحسين عليه السلام ، الحديث ٨.
(٢) كامل الزيارة : ٢٥٤ ، الباب ٤٩ ثواب من زار الحسين عليه السلام راكباً أو ماشياً ، ومناجاة الله لزائره ، الحديث ٤.
قال :يلزمك حسن الصحابة لمن يصحبك ، ويلزمك قلّة الكلام إلّا لخير ، ويلزمك كثرة ذكر الله ، ويلزمك الغسل قبل أن تأتي الحائر ، ويلزمك نظافة الثياب ، ويلزمك الخشوع وكثرة الصلاة والصلاة على محمّد وآل محمّد ، ويلزمك التوقي لأخذ ما ليس لك ، ويلزمك أن تغضّ بصرك ، ويلزمك أن تعود على أهل الحاجة من إخوانك إذا رأيت منقطعاً والمواساة ، ويلزمك التقية التي هي قوام دينك بها والورع عما نهيت عنه والخصومة وكثرة الأيمان والجدال الذي فيه الأيمان ، فإذا فعلت ذلك تمّ حجك وعمرتك ، واستوجب من الذي طلبت ما عنده بنفقتك واغترابك عن أهلك ورغبتك فيما رغبت أن تنصرف بالمغفرة والرحمة والرّضوان »(١) .
__________________
(١) كامل الزيارة : ٢٥٠ الباب ٤٨ كيف يجب أن يكون زائر الحسين بن عليّ عليهما السلام ، الحديث ١.
[التنبيه] التاسع :
في أنه هل يجوز الإكتفاء في زيارة عاشوراء
باللعّن والسلام مرة واحدة؟
أنّه هل يجوز الإكتفاء في كل من اللعن والسلام بالمرّة الواحدة أم لا؟
قيل : إنّه يعتبر في اللعن والتسليم الإتيان بكل منهما مائة مرة ولا يكفي الأقل.
أقول : إن مقتضى رواية علقمة في كل من رواية كامل الزيارة و «المصباح» اشتراط تكرار اللعن والتسليم مائة مرة ، ومقتضى رواية كامل الزيارة ورواية عقبة وإن كان عدم اشتراط المائة ، لكن مقتضاه اشتراط كمال الإكثار ، حيث إنه مقتضى الاجتهاد المأخوذ في الروايتين ، فلا يكفي المرة الواحدة على التقديرين.
نعم يتأتى الكلام لو صدق الاجتهاد بدون المائة ، فلو قلنا بحمل المطلق على المقيّد في المستحبّات ، فلابدّ من البناء على المائة ، وإلّا فيكفي ما دون المائة ، كما أنّه لو قلنا بحمل المطلق على المقيّد يكفي ما دون المائة أيضاً ، بناء على التسامح في المستحبّاب لو قلنا باطراده مع الظنّ المعتبر بالخلاف ، وأمّا الاكتفاء بالمرة الواحدة فلا وجه لحرمنه ، إلّا تطرق البدعة ، لكنها غير متطرقة مع الاطلاع على اعتبار التكرار مائة مرة.
نعم لو كان مبيناً على خيال فاسد ، كخيال من عند النفس ، أو اجتهاد غير معتبر ، أو تقليد غير معتبر ، كتقليد بعض العوام لبعض آخر ، أو بعض أرباب العلم الغير البالغ رتبة الاجتهاد أو المجتهد مع عدم اعتبار مدرك اجتهاده ، كما لو كان اجتهاده مبنياً على القياس ، يتأتى تطرق البدعة ، ويظهر الأمر كمال الظهور بملاحظة ما حرّرناه في الأصول في باب البدعة في بحث التسامح في أدلّة السنن.
[التنبيه] العاشر :
في أنه هل يجوز الإتيان بزيارة عاشوراء في مجالس متعددة
أو ماشياً أو راكباً أم لا؟
وعلى الثاني هل تعتبر الموالاة في أجزائها أم لا؟
أنّه هل يجوز الإتيان بالزيارة المبحوث عنها على النظم المتقدّم في مجالس متعددة أو ماشياً أو راكباً أو في السفينة أم لا؟
وعلى الثاني(١) هل يعتبر الموالاة في أجزائها أم لا؟
(أمّا الثاني )(٢) : فالظاهر من أخبار الزيارة اعتبار الموالاة فلو تخلل الفصل في البين ، فالظاهر لزوم الاستيناف ، نعم لو كان الفصل لا ينافي الاتصال عرفاً ولا يوجب عدم صدق الاسم وانمحاء الصورة سواء كان الفصل بالإختيار كشرب الماء أو بالإضطرار كالتعطس ، فلا بأس بالفصل ، وعلى هذا المنوال تجري الحال في جميع المركبات المركبة من الأقوال والأفعال أو الأقوال أو الأفعال ، ومنه الوضوء وغيره.
وربما فُصِّلَ في الفصل المتخلل المخلّ بالإتصال عرفاً بين الإضطرار والإختيار ، بارتفاع الموالاة ولزوم الاستئناف على الثاني(٣) دون الأوّل(٤) ، فيجوز فيه إتمام العمل.
__________________
(١) وهو عدم جواز الإتيان بها على النظم المتقدّم.
(٢) وهو عدم اعتبار الموالاة.
(٣) وهو الاختيار.
(٤) وهو الاضطرار.
وأنت خبيرٌ بأن المانع عن إلتيام الصورة وتحقّق الهيئة أعني الصحّة لا يختلف ممانعته بالإختيار والإضطرار ، فقضية عدم اختلاف الأحكام الوضعيّة والآثار القهرية بالإختيار والإضطرار ، نعم جواز ارتكاب المانع يختلف بالإختيار ، لكنه أمر آخر ليس الكلام فيه ، بل ارتكاب المانع هنا بالإختيار لاريب في جوازه.
وأمّا الأوّل (١) : فإن كان تعدّد المجلس بحيث لا يخل بالموالاة ، كما لو ذهب من سطح داره إلى سطح آخر أو من موضع من الصحراء إلى موضع آخر من دون إخلال بالموالاة مع كون الزيارة إلى جهة قبر سيّد الشهداء عليه السلام فلا بأس به ، وإلّا فتبطل الزيارة ، قضيّة انمحاء الصورة وعدم صدق الاسم.
ولا فرق في الباب بين الإختيار والإضطرار ، وأما المشي والركوب والكون في السفينة فلا يشملها أخبار الزيارة بعد كونها في جهة قبر سيّد الشهداء عليه السلام وإلّا فالظاهر بطلان الزيارة إذ مقتضى الأخبار اعتبار الجهة.
ولا فرق في الباب أيضاً بين لزوم المشي أو الركوب أو الكون في السفينة وارتكاب الزيارة بعدها أو عروض الإضطرار إلى المشي أو أحد من أخويه بعد الشروع في الزيارة ، هذا مع قطع النظر عن الصلاة والسجدة ، وإلاّ فعدم شمول الصّلاة في أخبار الزيارة للصلاة ماشياً أو راكباً بعد صحة صلاة الزيارة ماشياً أو راكباً من باب القطع بعدم الفرق بينها وبين النافلة(٢) أظهر من عدم شمول السلام الطويل واللّعن والسّلام المكرّرين لما يكون ماشياً أو راكباً أو في السفينة ، وعلى ذلك المنوال حال السجدة
__________________
(١) وهو اعتبار الموالاة.
(٢) قوله : «بينها وبين النافلة أظهر» بناء على جواز النافلة ماشياً أو راكباً ، ولو في الحضر بالاختيار ، كما يدلّ عليه الأخبار ، وهو اختيار من عدا العماني والأحسائي نقلاً ، حيث إنّهما خصّا الجواز بالسفر ، وجوازها في السفينة كما يدلّ عليه غير واحد من الأخبار ، بل الأخبار كما في الغنائم ، والظاهر أنّه لا خلاف فيه. منه رحمه الله.
ماشياً أو راكباً بالإيماء بالرأس أو غيره ، فإن عدم شمول السجدة في أخبار الزيارة للسجدة ماشياً أو راكباً أظهر من عدم شمول السلام وأخويه لما يكون ماشياً أو راكباً.
وربّما فُصِّلَ (١) : بأنّه إذا كان راكباً أو في السفينة فكان مجلسه بحاله ولم يتعدّد له المجلس ، سواء كان في حال الإختيار أو الإضطرار ، ويجوز الإتيان بصلاته حال الركوب مومياً ، كما هو شأن صلاة النافلة.
وأما في حال المشي فإن كان ذلك في حاجة لازمة أو راحجة كعيادة مريض أو تشييع جنازة أو قضاء حاجة مؤمن أو نحو ذلك فلا بأس ، ولكن إذا عرضت له هذه الحوائج وهو في أثناء الزيارة فلا يترك عمله بل يأتي بها متشاغلاً به.
وأما إذا كان مشيه إلى الحاجة قبل الشروع في الزيارة ، فإن لم يخف الفوت بالتأخير إلى زمان القرار فالأولى والأحوط التأخير ، وإن خاف الفوت فليومِ إليه عليه السلام بأوّل السّلام ، ثم يأتي بالباقي على الوجه الذي إليه مشيه ، وإن لم يكن في حاجة لازمة ولا راجحة فالإتيان بها بقصد التوظيف لا يخلوا عن إشكال ، وقد يُستأنَسُ بعضُ ما ذكرناه بروايات وردت في الطواف ، ثم إنّه إذا كان مشغولاً بالعمل حال مشيه في موضع الجواز وجاء وقت السجدة أو الصلاة فالظاهر عدم جواز الإيماء وإن كان الأفضل حينئذٍ اختيار مكان لأجل السّجود والصّلاة ، بحيث لا يخلّ بالموالاة ، وإلاّ فليقتصر على الإيماء ، ومن ذلك يظهر الحال في إتيانها في مجالس عديدة ، فإنه إذا كان ذلك لأجل حاجة ضروريّة جاز إذا لم يخل بالموالاة ، وكذا الحوايج الراجحة شرعاً ، وإلاّ فإن كانت المجالس في حكم مجلس واحد فلا بأس بذلك ، كما إذا كان في سطح واحد فزار في موضع وأتى باللّعن في موضع آخر وهكذا ، وإن كانت المجالس متعدّدة فإن أخلّ مع ذلك بالموالاة من دون عارض يمنعه عن إتمام العمل في المجلس الأوّل فالظاهر عدم الصحّة ولزوم الاستيناف لو أراد الإتيان بهذا العمل
__________________
(١) لم نعثر على المفصّل.
على وجه الصحّة وإن لم يخلّ بالموالاة ، كما إذا أخلّ بها وقد عرض له أمر عاقه عن إتمام العمل ، فإن الظاهر جواز البناء وعدم لزوم الاستيناف.
أقول : إنّ ما ذكره(١) في باب الركوب والكون في السّفينة فإن كان المقصود شمول أخبار زيارة عاشوراء ، كما ربّما يفصح عنه قوله فإنّما مجلسه بحاله ولم يتعدّد له المجلس فهو ظاهر الضّعف ، ولا سيّما بالنسبة إلى الصّلاة ، وإن كان المقصود القطع بعدم الفرق فلا يخلو عن الوجه بعد فرض كون الركوب وحركة السفينة في جهة قبر سيّد الشهداء عليه السلام ، ولعلّ الفرض المذكور هو ظاهر كلامه.
وأما ما ذكره : في باب المشي في حاجة لازمة أو راجحة.
فمحصوله أنه لا يمانع عن الشروع ولا عن الإتمام.
ويُضعفُ : بأنّه يتأتى الكلام ، تارة في ممانعة المشي في حاجة لازمة أو راحجة عن صحّة الزيارة ، وأخرى في ترجيح المشي على الزيارة بدون المشي ، أمّا الأوّل فهو الذي ينبغي التكلّم فيه في المقام ولا خفاء في عدم ممانعة لزوم المشي أو رجحانه عن فساد الزّيارة ، كما أنّ الصّلاة مثلاً لا يختلف فسادها بارتكاب ما يفسدها من الفعل الكثير بلزوم الفعل الكثير أو رجحانه وعدمهما ، وظاهره القول بالصحّة في المقام ، ويظهر فساده بما سمعت.
وأمّا الثاني فلابدّ فيه من ملاحظة الأهميّة في صورة رجحان الحاجة ولا يصحّ ترجيح المشي إلى الحاجة الرّاجحة ، نعم لزوم الحاجة يوجب ترجيح المشي إليها على الإطلاق.
وأما ما ذكره من أنّه إن خاف فوت الزيارة بالتأخير إلى زمان القرار فليومِ إليه بأوّل السلام.
__________________
(١) المُفَصَّل الذي تقدّم ذكره في قوله المتقدّم : «وربّما فصّل».
فيُضعفُ بأنّه إن تعذّر السلام بالتمام ولم يأت بتمام السّلام فلا جدوى في الإتيان بأوّل السلام ، إلّا أن يكون مبنياً على زعم كون المقصود بالإيماء بالسّلام هو الإيماء بالسّلام المندوب ، أعني أوّل السلام ، وليس بشيء إذ المقصود بالإيماء بالسّلام إما أن يكون الإيماء من السّلام إلى السلام أعني مجموع السّلام الطويل واللّعن والسّلام المكرّرين أو السّلام الطويل ، وعلى التقديرين لا يكفي السّلام المندوب ، أن يكون مبنياً على أنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، إلّا أن قاعدة الميسور والمعسوُر غير تامة ، ولا سيّما في المستحبّات على الأظهر ، وقد حرّرنا تفصيل الكلام في الأصول ، مع أن مجرى تلك القاعدة إنّما هو ما لو تعذّر بعض أجزاء المركّب ، والأمر في المقام من باب تعذّر الشرط بتمامه إذ الإيماء من باب شرط الزيارة ، وهاهنا قد تعذّر الإتيان به في تمام الزيارة وإنّما أمكن الإتيان به في أوّل السلام ، هذا على تقدير كون المقصود بالإيماء الإشارة بالإصبع ، وأما لو كان المقصود من الإيماء إليه هو توجيه السّلام نحوه ، فلعلّ الظاهر كون الأمر من باب الجزئيّة ، وأمّا لو قلنا بعدم اشتراط الإشارة بالإصبع ، كما يأتي ، فلا حاجة إلى الإيماء لو كان المقصود به الإشارة بالإصبع ولو في أوّل السّلام.
وأمّا ما ذكره : من أنّه إن لم يكن المشي في حاجة لازمة ولا راجحة فالإتيان بالزّيارة بقصد التوظيف لا يخلو عن إشكال.
فيُضعفُ : بأنّه لا إشكال في عدم جواز قصد التوظيف ، ومقتضى كلامه خلو قصد التوصيف عن الإشكال ، بل الحق عدم إمكان قصد التوظيف مع الاطّلاع والالتفات إلى عدم شمول الأخبار ، وإن أمكن تصور التّوظيف ، لكن تصوّر الحرام لا يكون حراماً ، نعم يمكن التصديق في صورة عدم الاطلاع على عدم شمول الأخبار من باب الخرص والتخمين أو التقليد الفاسد ، وحينئذٍ يتأتى الحرمة.
وأمّا ما ذكره : من استيناس بعض ما ذكره بروايات وردت في الطواف.
فيُضعّفُ : بأن الاستيناس لا جدوى فيه ، لأنّه لا يخرج عن القياس فتدبّر.
وأمّا ما ذكره : من أنّ الظاهر جواز الإيماء فيما إذاكان مشغولاً بالعمل حال مشيه في موضع الجواز وجاء وقت السّجدة أو الصّلاة.
فيُضَّعفُ : بأن دعوى الظهور مع إمكان أخذ مكان لأجل السجود أو الصّلاة بحيث لا يخلّ بالموالاة ، كما هو المفروض في ظاهر كلامه محلّ الإشكال ، بل الظاهر العدم ، هذا والتعرض لحال السجدة والصّلاة في كلامه المذكور يكشف عن عدم دخول حالهما فيما يقتضيه كلامه المتقدّم من الشروع في الزيارة عند سبق المشي وإتمامها عند عروض المقتضى للمشيّ وإلاّكان الظاهر دخول حالهما فيما يقتضيه كلامه المتقدّم.
وأمّا ما ذكره : من الإقتصار على الإيماء في صوره عدم إمكان أخذ مكان لأجل الصّلاة.
فيُضعّفُ : بأن المفروض دوران الأمر بين فوت الموالاة وفوت القيام وغيره في الصّلاة ووضع الجبهة في السجود واختيار الثاني لابدّ له من مستند وحجّة.
وأمّا ما ذكره : من جواز الإتيان بالزّيارة في مجالس عديدة لأجل حاجة ضروريّة أو راجحة شرعاً.
فيُضعّفُ : بما يظهر مما تقدم.
وأما ما ذكره : من أنّ الظاهر جواز البناء وإتمام العمل لو عاقه أمر عن إتمام العمل في المجلس الواحد وأوجب تعدد المجلس.
فيُضعّفُ : بما يظهر مما مر من أنّ الإضطرار إلى ارتكاب المانع لا يمانع عن ممانعة المانع عن الصحة والتيام الطبيعة ، لعدم اختلاف الأحكام الوضعية والآثار القهريّة بالإختيار والإضطرار.
وربّما يتوهّم : أنّ مقصوده بما ذكره هو دعوى الظهور فيما لو عاق أمر عن الموالاة بمجرّده ولو في المجلس الواحد.
وهو مدفوع : بأنّه قد تقدّم منه ذكر ما لو عاق أمر عن الإتمام في المجلس الواحد ، وحكم فيه بالإتمام ، ولا مجال للتكرار مع أنّ مقتضى السياق وكون دعوى الظهور المذكور في تلو أحكام تعدد المجلس هو كون تلك الدعوى في باب تعدد المجلس.
[التنبيه] الحادي عشر :
في أنه هل يجوز كون السّلام الطويل
اللّعن والسّلام المكرّرين بالقعود؟
إنّ الظاهر أنه لا إشكال في جواز كون دعاء الوداع أعني دعاء صفوان بالقعود ، وكذا الحال في الدعاء قبل السجدة ، وهل يتعيّن كون السلام الطويل واللعن والسّلام المكررين بالقيام أو يجوز كونهما بالقعود؟
أقول : الظاهر إن فعل صفوان كان بالقيام ، كما هو المعهود المتعارف خلفاً بعد سلف غالباً ، بل الظاهر أنّ إطلاق الأخبار ينصرف إلى القيام ، بل يمكن دعوى استمرار السيرة على القيام في باب السّلام الطويل ، بل الاعتبار يقتضي تعيّن كون السّلام الطويل والمكرر بالقيام ، ولا سيّما بالنسبة إلى القريب إذ السّلام هنا بمنزلة السّلام والمكالمة مع سيّد الشهداء عليه السلام بالمشافهة ولا ريب أنّ حسن الأدب يقتضي كون السّلام والمكالمة في صورة المشافهة بالقيام ، نعم اللّعن من باب الدعاء والمكالمة مع الله سبحانه ، ولا بأس بكونه بالقعود ، كما أنه لم يتعيّن في دعاء من الأدعية كونه بالقيام لتنزّه الله سبحانه عن التعيّن في جهة من الجهات ، ويرشد إلى حسن مراعاة الأدب ، بل لزومها ما حكي من أنّ بعض الأعلام في بعض أيام التحصيل رأى سيّد الشهداء عليه السلام في النوم فسلّم عليه فأعرض عنه فسُئلَ عن وجه الإعراض ، فقال : قلت لفلان فتسارع بعض الأعلام في اليوم إلى الفلان وهو صار من العلماء وسئل عن مقالة سيّد الشهداء عليه السلام ، فقال إنّي رأيته في النوم قال لي : إنّ بعضاً لا يبالي ويجيب عن السؤال بمحضري ، فتفطّن بعض الأعلام بما صنعه حيث أجاب عن السؤال في بقعته الشريفة.
[التنبيه] الثاني عشر :
في أنّ التكلّم في خلال زيارة عاشوراء هل يوجب فسادها؟
أنّ التكلّم في خلال الزيارة هل يوجب فسادها أم لا؟
أقول : لا ينبغي الإشكال في عدم الفساد ، لو لم يكن التكلّم ماحياً للصورة والاتصال وصدق الزيارة عرفاً ، وأما لو كان التكلّم ماحياً للصورة ، فيمكن القول بالبطلان ولزوم الاستئناف ، بل لعل الأمر خال عن الإشكال.
[التنبيه] الثالث عشر :
فيما تعارف من الإشارة بالإصبع
في حال الزيارة في زيارة عاشوراء
أنّه قد تعارف بين الخواصّ والعوام الإشارة في حال الزيارة بإصبع السبّابة ، والظاهر أنّها يقال لها إصبع الشهادة أيضاً.
ولعلّه مبنيّ على حمل الإيماء في رواية مالك وعلقمة وعقبة على الإشارة بالإصبع.
وليس بشيء إذ الإيماء لغة بمعنى مُطلق الإشارة ، قال في الصحاح : «وَمَأَ وأومأتُ إليهِ : أشرتُ»(١) .
وفي «المصباح» : «أوْمَأتُ إليهِ أشرْتُ بحاجبٍ أو يدٍ أو غيرِ ذلكَ»(٢) .
وفي القاموس : «وَمَأ إليهِ كوضعَ أشارَ كأومأ وومأ ، وتقدم في وَبأ»(٣) ، وذكر في وَبأ : أن «وبأ إليه بمعنى أشار ، قال والإيباء الإشارة بالأصابع من أمامك ليُقبِلَ ، والإيماء من خلفك ليتأخّر» ، وفي بعض النسخ : «والإبياء».
وعلى الأوّل المقصود استعمال الإيماء في الإشارة بالأصبع من الخلف للتأخّر ، وعلى الثاني المقصود الترديد في الإيباء بين كونه مُطلق الإشارة أو الإشارة من الأمام قبال الإيماء المقصود به الإشارة من الخلف ، والمقصود بما ذكره في الإيماء :
__________________
(١) صحاح الجوهري : ١: ٨٢ ، مادّة «ومأ».
(٢) المصباح المنير : ٦٧٣ ، مادة «ومأ».
(٣) القاموس المحيط : ١: ١٤٦ ، مادّة «وبأ».
أنّه يمعنى مُطلق الإشارة ، ويستعمل في قبال الإيباء ، ولا مجال للترديد في المقام ، إذ مقتضى العبارة على تقدير كونها با وهو الترديد في الإيباء لا الإيماء ، ولا يسرى الترديد في الإيباء إلى الإيماء ، ولم يقل أحد بكون الإيماء هو الإشارة بالإصبع ، فلا مجال لحمل الإيماء في رواية مالك وأخويه(١) على الإشارة بالإصبع ، بل المراد التوجه ، فالغرض من الإيماء بالسّلام هو توجيه السّلام وقصد سيّد الشهداء عليه السلام بالسّلام.
ويرشد إليه ما رواه في «كامل الزيارة» : عن سليمان بن عيسى ، عن أبيه ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كيف أزورك إذا لم أقدر على ذلك؟
قال :يا عيسى ، إذا لم تقدر على المجيء ، فإذا كان في يوم الجمعة فاغتسل أو توضّأ ، واصعد إلى سطحك ، وصلِّ ركعتين ، وتوجّه نحوي »(٢) ، فإنّ المقصود بالتوجّه نحوه عليه السلام هو التوجّه بالزيارة.
وكذا ما رواه في «كامل الزيارة» بسنده : عن حنان ، عن أبيه ، قال : «قال لي أبو عبد الله عليه السلام :يا سدير ، تكثر زيارة قبر الحسين بن عليّ عليه السلام ؟
قلت : إنّه من الشغل.
فقال :ألا اُعلّمك شيئاً إذا أنت فعلته كتبت لك بذلك الزيارة ؟
فقلت : بلى جعلت فداك.
فقال لي :اغتسل في منزلك ، واصعد إلى سطحك ، وأشر إليه بالسّلام »(٣) ، حيث إنّ قوله عليه السلام : «وأشر إليه» ظاهر كمال الظهور في أنّ المقصود بالإيماء
__________________
(١) يعني أخويه في الرواية ، وهما علقمة وعقبة.
(٢) كامل الزيارة : ٤٨٢ ، الباب ٩٦ مَن نأت داره وبعدت شقّته كيف يزوره عليه السلام ، الحديث ٤.
(٣)كامل الزيارة : ٤٨٢ ، الباب ٩٦ مَن نأت داره وبعدت شقّته كيف يزوره عليه السلام ، الحديث ٥.
هو مجرّد الإشارة.
ويرشد إليه أيضاً ما في رواية عبد الله بن سنان المروية في «المصباح» : «ثم تسلّم ، وتحوّل وجهك نحو قبر الحسين عليه السلام ومضجعه ، فتمثّل لنفسك مفزعه ، ومن كان معه من ولده وأهله ، وتسلّم وتصلّي عليه ، وتلعن قاتليه »(١) ، قضية الإكتفاء فيه بصرف الوجه.
وكذا ما حكاه سيف بن عميرة ، عن صفوان : «من أنّه صرف وجهه إلى ناحية أبي عبد الله عليه السلام فقال :تزورون الحسين عليه السلام من هذا المكان من عند رأس أمير المؤمنين عليه السلام من هاهنا ، وأومئ إلى أبي عبد الله عليه السلام ، حيث إنّ صفوان اكتفى بصرف الوجه ، والظاهر أنّ الغرض نقل ما فعله عن أبي عبد الله عليه السلام وتطبيق فعله على فعل أبي عبد الله عليه السلام ، ولا يتأتّى ذلك إلّا على تقدير كون الغرض من الإيماء هو توجيه الوجه.
لكن يمكن أن يكون الغرض من الإيماء هو توجيه السّلام ، فصرف الوجه تمهيد للزيارة ، لكنّه ـ أعني صفوان ـ قد حكى بعد ذلك ما فعله عن الصادق عليه السلام ، وربّما يرشد إليه ما في بعض زيارات عاشوراء : «ثم ارفع يديك ، واقنت بهذا الدعاء ، وقل وأنت تومئ إلى أعداء آل محمّد صلى الله عليه وآله : اللهمّ إن كثيراً من الاُمّة ناصبت المستحفظين من الأئمّة عليهم السلام»(٢) إلى الآخر ، حيث إنّ المقصود بالإيماء فيه هو القصد ليس إلّا.
وبعد هذا أقول : إنّ في بعض الروايات أنّ شخصاً كان يكثر زيارة سيّد الشهداء عليه السلام لكنّه بسبب الهرم والفقر تقاعد عن الزيارة فرأى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وآله وعنده سيّدا شباب أهل الجنة ، فلما قرب إليهم قال سيّد الشهداء عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله : إن هذا الشخص كان يكثر الزيارة ، والحال ترك الزيارة.
__________________
(١) مصباح المتهجّد : ٧٨٣.
(٢) مصباح المتهجّد : ٧٨٤.
فتوجّه رسول الله صلى الله عليه وآله إليه وقال :زيارة الحسين هل يمكن تركها.
فقال : يا رسول الله ، الهرم والفقر يمانعا عن الزيارة.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله :اصعد كلّ ليلة على سطح دارك ، وأشر بإصبع الشهادة إلى قبر الحسين ، وقل : إلى آخر الزيارة».
وفي رواية أخرى : «إنّ شخصاً جاء مع سكينة ووقار ، وقام في روضة سيّد الشهداء عليه السلام ، وأشار بيده إلى جانب الضريح وأتى الزيارة.
وذكر العلّامة المجلسي قدس سره : أن الظاهر أنّ الزائر كان هو الخضر عليه السلام أو أحد من الأئمّة عليهم السلام.
لكنّك خبيرٌ بأن شيئاً من الروايتين لا عبرة بهما في إثبات اشتراط الإشارة بالإصبع ، لعدم اعتبار النوم في الأولى ، وعدم تعيّن الزائر بعد سلامة السند فيهما.
تذييلان
أحدهما : في أنّ الإشارة بالإصبع بناء على اعتبارها في الزيارة هل تختصّ
بالسّلام الطويل أو يطرّد في اللّعن والسّلام المكرّرين؟
إنّ الإشارة بالإصبع بناء على اعتبارها هل تختص بالسّلام الطويل أو تطرد في اللعن والسّلام المكرّرين؟
ربّما قيل : إنّ الأوْلى والأفضل الإيماء إلى قبره عليه السلام في تمام الزيارة ، كما هو ظاهر الرواية.
وإن كان للاكتفاء به في أصل السّلام دون غيره من اللعن والتسليم وجه.
أقول : إنّه لو كان المقصود بالسّلام المومى إليه هو الزيارة لا مطلق السّلام ، كما هو المفروض ، فلا بدّ من اطراد الإشارة في تمام الأجزاء فلا بدّ من الاطّراد في اللّعن والسّلام المكرّرين ، ولا مجال لكفاية الإشارة في السّلام الطويل.
إلّا أن يقال : أنّ الكلّ المعلّق عليه الحكم ربّما ينصرف إلى بعض الأجزاء ، كما أنّ الكلّي عليه الحكم ربما ينصرف إلى بعض الأفراد ، كيف وقد شاع وذاع أن المطلق ينصرف إلى الفرد الشائع ، بل كثيراً ما ينصرف المطلق إلى بعض الأفراد من غير جهة الشيوع ، ويأتي مزيد الكلام في هذا الباب ، فلا بأس بانصراف السّلام المومي إليه إلى السّلام الطويل.
لكنّه مدفوع : بأنّه إنّما يتم لو لم يكن تعلق الحكم في مقام بيان تشريع حكم الكل مع فرض انحصار دليل التشريع وإلّا فلا مجال للانصراف ، إذ لو انصرف الكل إلى بعض الأجزاء فلا دليل على تشريع الباقي ، ويبقى الباقي بدون دليل على التشريع ، والمفروض تشريع تمام الأجزاء ، والأمر في المقام من هذا القبيل.
إلّا أن يقال : إنّه يمكن أن يكون تشريع الباقي من الأجزاء ثابتاً بالإجماع لا يشمول الكل ، ولا بأس به ، وهذا نظير أنه لو ثبت اطراد حكم المطلق في بعض الأفراد النّادرة ، بناء على انصراف المطلق إلى الفرد الشائع ، فاطّراد الحكم لا يكشف عن شمول المطلق لجميع الأفراد بكون المراد بالمطلق هو الأعم من تلك النوادر ، فيرتفع ظهوره في الفرد الشائع ويصير ظاهراً في الأعم وأنّه لو كان اللّفظ موضوعاً لمعنى وثبت الحكم المتعلق بذلك اللّفظ في معنى آخر بالاجماع مع إمكان التجوّز باللّفظ عن المعني الأعم من المعنيين ، فهذا لا يصير قرينة على المجازية بكون اللّفظ مستعملاً في الأعم ، كما في قوله سبحانه : ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) (١) ، حيث إنّ الإخوة حقيقة فيما فوق الاثنين ، بناء على كون أقل الجمع ثلاثة ، كما هو المشهور المنصور ، والحكم المذكور أعني الحجب ثابت في الأخوين بالاجماع ، وإمكان استعمال الإخوة فيما فوق الواحد مجازاً لا يمانع عن الاستعمال فيما فوق الاثنين حقيقة وإن اطراد الحكم المطرّد في غير مورد العلّة بناء على عدم اعتبار
__________________
(١) النساء ٤: ١١.
مفهوم العلة وثبوت التخصيص بها لا يمانع عن التخصيص.
لكن نقول : إنّ المفروض انحصار مدرك التشريع فيما لو انصرف إلى بعض الأفراد ويبقى الباقي خالياً عن التشريع ، فعلى هذا لابدّ من كون مدرك الاجماع هو عموم الكل لتمام الأجزاء ، فالاجماع يكشف عن عموم المدرك لجميع الأجزاء ولا مجال لكون الاجماع مدركاً بنفسه ، والأمر في المقام من هذا القبيل لانحصار ما يثبت تشريع اللّعن والسّلام فيما دل على الإيماء ولو انصرف هذا إلى السّلام يبقى اللعن والسّلام خالياً عن دليل التشريع.
ثانيهما : في كلام من العلّامة المجلسي قدس سره في الإشارة بالإصبع في زيارة سيّد الشهداء عليه السلام
إنّ العلّامة المجلسي قدس سره في «زاد المعاد في بيان أعمال ليلة النصف من شعبان» بعد أن روى مرسلاً عن الصادق عليه السلام : «أنّ في نصف ليلة النصف من شعبان يغفر الله جميع ذنوب من زار سيّد الشهداء عليه السلام » ، قال قدس سره : «واقلّ زيارت آن حضرت آن استكه ببامى يا صحن ﮔﺸﺎﺩﻩ درآيد وبجانب راست آسمان وبجانب ﭼﭗ وبه بالاى سر نظر كند ﭘﺲ باﻧﮕﺸﺖ إشاره كند بجانب راست قبله ﭘﺲ ﺑﮕﻮيد : السّلام عليك يا أبا عبد الله ، السّلامُ عَليكَ ورحمةُ اللهِ وبركاته».
أقول : إن هذا مضمون ما رواه الفقيه مرسلاً عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن الصادق عليه السلام ، كما مر ، حيث قال عليه السلام : «اصعد فوق سطحك ، ثم التفت يمنة ويسرة ، ثم ارفع رأسك إلى السماء ، ثم تنحو نحو قبر الحسين عليه السلام فتقول : السّلام عليكَ يا أبا عبد الله ، السّلامُ عَليكَ ورحمةُ الله وبركاته ...»(١) ، فالمدار في كلامه
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ٢:٥٩٩ ، باب ما يقوم مقام زيارة الحسين عليه السلام وزيارة غيره ، الحديث ٢.
على بيان أقلّ ما يتحقّق به زيارة سيّد الشهداء عليه السلام.
لكن نقول : إنّه(١) زاد كفاية البروز إلى الصحراء ، وليس هذا بمتجه وإن اتّجه تقييد تلك الرواية بعد اعتبار سندها بصدر رواية «كامل الزيارة» وصدر رواية «المصباح» ، بعد اعتبار سندهما لاقتضائهما التخيير بين الصعود إلى السطح والبروز إلى الصحراء في الزيارة يوم عاشوراء ، وقد تقدّم الكلام فيه.
ومع هذا نقول : إنّه قد زاد : «السّلام عليك يابن رسول الله» مع خلو تلك الرواية عنه وكفاية ما ورد في الرواية في أقل ما يتحقّق به الزيارة وهو الذي يكون كلامه في بيانه.
ومع هذا نقول : إنّه ليس في تلك الرواية إشارة إلى الإشارة بالإصبع ، وهو قد اعتبر الإشارة بالإصبع.
إلّا أن يقال : إنّ اعتبار الإشارة بالإصبع من باب اعتبار الإيماء في الروايات.
لكنّه مدفوع : بما مر من أنّ المقصود بالإيماء هو توجيه السّلام.
ومع هذا نقول : إنّ اعتبار كون الإشارة بالإصبع إلى جانب القبلة بعد خلو تلك الرواية عنه لم أظفر به في رواية من الروايات.
إلّا أن يقال : إنه مبنيّ على استخراج جهة القبر بالدائرة الهنديّة(٢) كاستخراج القبلة.
__________________
(١) يعني به العلّامة المجلسي في زاد المعاد.
(٢) نظير الأمر في المقام ما ذكره المحقّق القمّي من أنّهم ادّعوا الإجماع في مسألة القبلة ، على أنّ من بنى على الظنّ فيها بعد العجز عن تحصيل العلم ، ثمّ ظهر له الانحراف عنها ما بين المشرق والمغرب ، فيصحّ إجماعاً ويستدير إلى القبلة ، وإلّا فيبطل ، مع أنّ دعوى الإجماع لا تصحّ إلّا في القبلة إلى العراق وأشباهه ، مع أنّ الفقهاء أطلقوا المسألة ، وقد تكون القبلة في نقطة المشرق أو نقطة المغرب. منه رحمه الله.
لكن نقول : إنّ مقتضى كلامه كون قبر سيّد الشهداء عليه السلام في جانب يمين القبلة ، وقد صرّح بعض الأصحاب باختصاصه بأكثر البلاد المشهورة من العراق بتفاوت فيها في انحراف القبر عن القبلة ، حيث إنّ الانحراف في إصفهان بثلاثة وخمسين درجة وفي شيراز بخمسة وستين درجة ، وفي مشهد المقدّس الرضوي بسبعة وستّين درجة ، وفي قزوين باثنين وثلاثين درجة ، وقد يكون القبر في جانب اليسار بدرجة.
وقال بعض الأعلام : إنّ التوجّه إلى أرض قدس كربلاء في إصفهان ومثله من بلاد إيران يحقّق بالميل من سمت القبلة بجانب المغرب ، ومقدار الميل يختلف بزيادة طول البلد وعرضه ونقصانه.
مضافاً إلى ما عن بعضٍ من القدح في استخراج القبلة وجهات قبور الأئمّة بالدائرة الهندية بوجوه.
ومع ذلك نقول : إنّ ما ذكره يختصّ بالبعيد ، واستحباب الزيارة ليلة النصف من شعبان يعمّ القريب.
اللهمّ إلاّ أن يكون عمدة البناء في زاد المعاد على ذكر زيارة البعيد ، كما هو مقتضى ما تقدم من كلامه.
[التنبيه] الرابع عشر :
في أنّ الزيارة السابقة على زيارة عاشوراء على ما رواه في «المصباح» هي زيارة أمير المؤمنين عليه السلام بالزيارة السادسة كما هو مقتضى ما رواه محمّد بن المشهدي واختلاف الروايتين من وجوه ، واختلاف دعاء الوداع على ما رواه «المصباح» لو كان الأمر على ما رواه محمّد بن المشهدي
إنّ الزيارة السابقة على زيارة عاشوراء ، أي المقصود بالزيارة المفروغ عنها في رواية «المصباح» في قول سيف بن عميرة : «فلمّا فرغنا من الزيارة» هو زيارة أمير المؤمنين عليه السلام ، بقرينة قوله : «خرجت مع صفوان بن مهران الجمّال وجماعة من أصحابنا إلى الغريّ» ، وزيارة أمير المؤمنين عليه السلام إنّما كانت بالزيارة السادسة ، كما هو مقتضى رواية محمّد بن المشهدي ، لكن بين رواية «المصباح» ورواية محمّد بن المشهدي اختلاف من أربعة وجوه :
أحدها : إنّ رواية محمّد بن المشهدي لا توافق رواية «المصباح» في باب الزيارة إلاّ في قوله : السّلامُ عَليك يا أبا عبد الله ، السّلامُ عليك يابن رسول الله» ، ومن هذه الجهة تخالف رواية محمّد بن المشهدي رواية «كامل الزيارة» أيضاً.
ثانيها : إنّ قوله : «أتيتكما زائراً ومتوسّلاً إلى الله» داخل في زيارة سيّد الشهداء عليه السلام ، بل هو صدر الزيارة في رواية محمّد بن المشهدي ، وفي رواية «المصباح» داخل في الوداع.
ثالثها : إنّ قوله : «أتيتكما زائراً» مؤخّر في رواية «المصباح» عن قوله : «يا الله ، يا الله» ، وفي رواية محمّد بن المشهدي مقدّم عليه.
رابعها : إنّ في رواية محمّد بن المشهدي قال : «ثم تلتفت إلى أمير المؤمنين عليه السلام وتقول :السَّلَامُ عَلَيْكَ يا أَميرَ الْمُؤْمِنينَ ، والسَّلَامُ عَلىٰ أَبي عبْدِ اللهِ الْحُسَيْن ما بَقِيتُ وَبَقِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ ، لَا جَعَلَهُ اللهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّي لِزيارَتِكُما ، وهذه الفقرات داخلة في الوداع في رواية «المصباح» من دون التفات إلى أمير المؤمنين عليه السلام.
وبالجملة فالظاهر ، بل بلا إشكال أنّ الزيارة المتقدّمة جزء الرواية المذكورة في صدرها الزيارة المعروفة بالزيارة السادسة لأمير المؤمنين عليه السلام ، وقد سبق أنّه ذكر تلك الرواية في «تحفة الزائر» نقلاً عن شيخنا المفيد ومحمّد بن المشهدي ، وذكره في «البحار» نقلاً عن شيخنا المفيد ، والوداع المذكور لتلك الزيارة المقدّمة هو الوداع المذكور في ذيل الزيارة السادسة ، ويرشد إلى ما ذكر ما حكاه في «البحار» عن السيّد ابن طاووس من أنه أورد الزيارة السادسة ، فقال : «ثمّ صلّ صلاة الزيارة ست ركعات إلى أن قال : ثم قم فزر الحسين عليه السلام من عند رأس أمير المؤمنين عليه السلام بالزيارة الثانية من زيارتي عاشوراء اتباعاً لما ورد »(١) ، فاقتصار الشيخ في «المصباح» على ذكر زيارة عاشوراء من جهة اختصاص الغرض ، قضيّة كونه في بيان أعمال المحرم.
وأما محمّد بن المشهدي فربما يقال : إنّه لما كان في مقام بيان زيارات الأئمّة فهو ذكر أولاً زيارة أمير المؤمنين عليه السلام عند ذكر زياراته ، ولم يذكر زيارة سيّد الشهداء عليه السلام وإن اشتملت الرواية عليها لأنه كان يذكر زيارة كلّ إمام في مقام تختصّ به ، فذكر ما يتعلق بزيارة سيّد الشهداء عليه السلام.
لكن يخدشه اختلاف ما ذكره محمّد بن المشهدي من زيارة سيّد الشهداء عليه السلام بالاستقلال وما رواه من زيارة عاشوراء في ذيل رواية الزيارة السادسة ، ويظهر الحال بملاحظة ما تقدم ، وقد ذكر في «تحفة الزائر» : أنّ من قرائن الروايات المذكورة في زيارة أمير المؤمنين وسيّد الشهداء عليهما السلام يعلم أنّ أرباب تأليف الزيارات فرقوا حديث
__________________
السادسة ، وصرّح بعض آخر أيضاً : بكون المدار على التفريق.
وعلى أيّ حال ، لو كان الحال على منوال ما رواه شيخنا المفيد ومحمّد بن المشهدي فالوداع المرويّ في «المصباح» مورد اختلال الحال ويظهر الحال بما مرّ هنا وفي سالف المقال.
[التنبيه] الخامس عشر :
في خروج الصلاة عن الزيارة
أنه لا إشكال في رجحان السلام الطويل مع انضمام أخواته(١) المختتمة بالسّجدة ودعائها ، بل الظاهر اختصاص الزيارة بها وخروج الصلاة عن الزيارة ، ويرشد إليه قول أبي جعفر عليه السلام لعلقمة في رواية «كامل الزيارة» و «المصباح» : «وإن استطعت أن تزوره في كل يوم بهذه الزيارة فافعل» ، حيث إنّ الظاهر أنّ المراد من الزيارة تلك الأقوال ، أعني السّلام وأخواته(٢) ، وأما كون المراد هو مجموع الأقوال والصّلاة ، فهو خلاف الظاهر ، ويرشد إليه أيضاً استعمال الزيارة في الأقوال في رواية صفوان في كلام الإمام وصفوان وسيف بن عميرة.
أمّا الأوّل(٣) : فهو قول أبي عبد الله عليه السلام : «تعاهد هذه الزيارة وزر به » ، وقوله عليه السلام : «يا صفوان وجدت هذه الزيارة مضمونه بهذا الضمان » ، وقوله عليه السلام : «وقد آلى الله على نفسه عزّ وجلّ أن من زار الحسين عليه السلام بهذه الزيارة ، من قرب أو بعد ، ودعا بهذا الدعاء » ، وقوله عليه السلام : «يا صفوان ، إذا حدث لك إلى الله حاجة فزر بهذه الزيارة ».
ولو قيل : إنّ المقصود بالزيارة فيما ذكر هو مجموع الأقوال والصلاة.
قلت : إنه خلاف الظاهر ، كما مر.
وأما الثاني (٤) : فهو قول صفوان : «وزرت مع سيّدي أبي عبد الله عليه السلام إلى هذا
__________________
(١) مراده بأخواته اللعن المكرّر مائة مرّة ، والسلام المكرّر مائة مرّة ، وقوله : «اللّهمّ خصّ أنت».
(٢) مراده بأخواته ما ذكر في الحاشية السابقة.
(٣) مراده به كلام الإمام عليه السلام.
(٤) مراده به كلام صفوان.
المكان ففعل مثل الذي فعلناه في زيارتنا ، ودعا بهذا الدعاء عند الوداع بعد أن صلّى كما صلّينا ، وودّع كما ودّعنا».
وأمّا الأخير (١) : فهو قول سيف بن عميرة : «فدعا صفوان بالزيارة التي رواها علقمة بن محمّد الحضرمي ، عن أبي جعفر عليه السلام في يوم عاشوراء ، ثم صلّى ركعتين عند رأس أمير المؤمنين عليه السلام».
ولا يذهب عليك أنّه لا مجال لاحتمال استعمال الزيارة في مجموع الأقوال والصلاة في الأخيرين.
لكن نقول : إنّ الظاهر أنّ الزيارة حقيقة في مشاهدة الإنسان أو الأعم ، ومن الأخير ما يقال : «زرنا مكتوبك» ، فإطلاق الزيارة على مجموع السّلام وأخواته من باب المجاز ، فعلى ما ذكرنا فلا بأس بالاقتصار على السّلام وأخواته وعدم الإتيان بالصّلاة ، وأما قصد توظيف السّلام واخواته مع العلم بعدم توظيفه من باب التصديق وتصوّر التوظف مع العلم بعدم توظيفه ، فلا مجال لحرمته ، فينحصر أمر الحرمة فيما لو كان الاذعان بالتوظيف مستنداً إلى مدرك فاسد غير معتبر شرعاً اجتهاداً كان أو تقيداً أو خيالاً من عند النفس ، فالصّلاة من باب المستحبّ في المستحبّ ، أي يستحبّ الزيارة ويستحبّ أيضاً إردافها بالصّلاة ، لكن ترتب المثوبات الموعودة منوط بالإتيان بالصّلاة.
وربما قيل نقلاً : إنه لا كلام في كون الصلاة جزء الزيارة.
وليس بشيء ، لما يظهر ممّا سمعت من عدم دخول الصّلاة في مفهوم الزيارة ، بل عدم اشتراط الزيارة بالصّلاة ، لرجحانها في حدّ نفسها.
وبعد هذا أقول : إن مقتضى ما رواه علقمة عن أبي جعفر عليه السلام ، على ما رواه في
__________________
(١) مراده به كلام سيف بن عميرة.
«كامل الزيارة» من قوله عليه السلام : «فإنّك إذا قلت ذلك فقد دعوت بما يدعو به زوّاره من الملائكة ، وكتب الله لك بها ألف ألف حسنة ، ومحى عنك ألف ألف سيّئة ، ورفع لك مائة ألف ألف درجة ، وكنت كمن استشهد مع الحسين عليه السلام » ، وقوله عليه السلام ـ على ما في «المصباح ـ : «فإنك إذا قلت ذلك فقد دعوت بما يدعو به زوّاره من الملائكة ، وكتب الله لك مائة ألف ألف درجة » من المثوبات الموعودة على الزيارة ، ومع هذا الظاهر أنّ الزّوار من الملائكة إنّما يأتون بالزيارة نفسها دون الصلاة ، فمورد الدعاء بما يدعو به الملائكة وهو مورد المثوبات الموعودة هو الأقوال لا مجموع الأقوال والصلاة.
بقي أنّه قد تقدّم أنّ الظاهر خروج السجدة ، بل الدّعاء بالتخصيص عن الزيارة.
لكن نقول : إنّه لا بدّ من الإتيان بهما في ترتّب المثوبات الموعودة.
تذييلان
أحدهما : فيما لو أراد شخص الاقتصار على بعض أجزاء السّلام الطويل أو أراد ترك بعض إخوانه أو الصّلاة.
أنه لو أراد الشخص الإقتصار على بعض أجزاء السّلام الطويل قليلاً كان أو كثيراً ، أو أراد ترك بعض أخواته ، بناء على دخولها في الزيارة والظاهر أنه لا إشكال في الدخول أو أراد ترك الصّلاة بناء على دخولها في الزيارة فهل يصحّ ذلك أم لا؟
أقول : إنّه ربّما جرى العلّامة النجفي في «كشف الغطاء» على جواز القناعة في المندوب ببعض أجزائه فيما لم يثبت عدم استحباب بعض الأجزاء ، نظراً إلى انحلال الأمر إلى تعدّد الأمر.
وليس بالوجه ، فلا يتجه الصحة في الفروض المذكورة.
ثانيهما : فيما لو تعذّر بعض أجزاء السّلام الطويل أو بعض اخواته أو الصّلاة.
أنّه لو تعذّر بعض أجزاء السّلام الطويل أو تعذّر بعض أخواته أو تعذّر الصّلاة بناء على دخولها في الزيارة فهل يصحّ الإتيان بالباقي؟
أقول : إنّ الأمر يبتني على تمامية قاعدة الميسور والمعسور في باب المستحبات بعد تماميتها من أصلها ، وقد حررنا في الأصول عدم تماميتها من أصلها.
[التنبيه] السادس عشر :
في خروج دعاء الوداع عن الزيارة
وإناطة قضاء الحاجة بالإتمام به
أنه لا إشكال في خروج دعاء الوداع ، أعني دعاء صفوان عن الزيارة ، بل مقتضى ما ذكر في رواية مالك برواية كامل الزيارة ، ورواية قيس برواية «المصباح» من ثواب ألفي ألف حجّة وألفي ألف غزوة وغيرها ، هو ترتب الجزاء والثواب على الزيارة بالاستقلال ولا إشكال.
لكن مقتضى ما رواه صفوان إناطة قبول الزيارة وترتّب الثواب وقضاء الحاجة بالاتمام بالدعاء ، حيث إنّ مقتضى قول الصادق عليه السلام في رواية «المصباح» : «يا صفوان ، تعاهد هذه الزيارة ، وادع بهذا الدعاء ، وزر به ، فإنّي ضامن على الله تعالى لكلّ من زار بهذه الزيارة ، ودعى بهذا الدعاء ، من قرب أو بعد ، أنّ زيارته مقبولة ، وأن سعيه مشكور ، وسلامه واصل غير محجوب ، وحاجته مقضيّة من الله تعالى بالغاً ما بلغت ، ولا يخيبه ».
وكذا الحال في قوله عليه السلام : «وقد آلى الله على نفسه عزّ وجلّ إن من زار الحسين عليه السلام بهذه الزيارة ، من قرب أو بعد ، ودعا بهذا الدعاء ، قبلت زيارته ، وشفّعته في مسألته بالغاً ما بلغت ، وأعطيته سؤله ، ثم لا ينقلب عنّي خائباً ، وأقلبه مسرور العين ، قريراً عينه بقضاء حاجته ، والفوز بالجنة والعتق من النار ، وشفّعته في كل ما شفع ، خلا ناصب لنا » ، كما أنّ مقتضى قوله عليه السلام في آخر ما رواه صفوان : «يا صفوان ، إذا حدث لك إلى الله حاجة فزر بهذه الزيارة من حيث كنت ، وادع بهذا الدعاء ، وسل ربّك حاجتك تاتك من الله ، والله غير مخلف وعده رسوله » ، إناطة قضاء الحاجة بالاتمام بالدعاء ، ففي باب إناطة قضاء الحاجة بالاتمام بالدعاء ، ورواية صفوان خالية
عن معارضة رواية «كامل الزيارة».
ولو قيل : إنّ المقصود بالدعاء في الفقرات المذكورة هو نفس الزيارة ، كيف وبيان الزيارة من أبي جعفر عليه السلام في رواية «كامل الزيارة» و «المصباح» إنما وقع بعد سؤال علقمة من الصادق عليه السلام عن دعاء يدعو به إذا لم يزره من قريب ويومي إليه من بعد البلاد.
قلت : إن مقتضى ما ذكره صفوان بعد اعتراض علقمة في باب دعاء الوداع من أنّ الصادق عليه السلام فعل مثل ما فعله صفوان ، ودعا بدعاء الوداع ، وقال : «تعاهد هذه الزيارة وادع بهذا الدعاء » ، كون المقصود بالدعاء المشار إليه في هذه الفقرة هو دعاء الوداع بلا إشكال فيه أصلاً ، فمقتضى السياق كون المقصود بالدعاء في الفقرتين الأولين من الفقرات المذكورة هو دعاء الوداع أيضاً ، بل الفقرة الأخيرة لا مجال لاحتمال كون المقصود بالدعاء فيه هو نفس الزيارة.
وربما يتوهّم : عدم مزاحمة رواية صفوان لرواية مالك وقيس في باب اختصاص ترتب الثواب بالزيارة.
ويضعف : بأنّ مقتضى الفقرتين الأوليين المتقدّمتين من رواية صفوان هو إناطة ترتب الثواب وقضاء الحاجة بالاتمام بالدعاء ، لأخذ قبول الزيارة وشكر السعي وقضاء الحاجة في الأولى في الجزاء على الزيارة والدعاء ، وأخذ قبول الزيارة وقضاء الحاجة والفوز بالجنّة والعتق من النّار وغيرها في الثانية في الجزاء على الزيارة والدعاء ، وإن أمكن كون الأمر في الاُولى من باب اللّف والنشر المرتب ، بكون ترتّب قبول الزيارة وشكر السعي في جزاء الزيارة وكون قضاء الحاجة في جزاء دعاء الوداع.
[التنبيه] السابع عشر :
في أنّه إذا كان للزائر حاجة فليسأل الله سبحانه قضائها
بعد الفراغ عن دعاء الوداع
أنه إذا كان للزائر حاجة فليسأل الله سُبحانه قضائها بعد الفراغ عن دعاء الوداع ، قضيّة ما رواه صفوان في آخر ما رواه عن أبي جعفر عليه السلام في رواية «المصباح» ومحمّد بن المشهدي ، حيث روي عنه عليه السلام أنّه قال : «يا صفوان ، إذا حدث لك إلى الله حاجة فزر بهذه الزيارة من حيث كنت ، وادع بهذا الدعاء ، وسل ربّك تأتك من الله ، والله غير مخلف وعده رسوله ».
وربّما يدعى قضاء الاستقراء بكون وقت الدعاء بعد إتمام العمل أو حين الإتمام.
[التنبيه] الثامن عشر :
في أنّه لا فرق في استحباب زيارة عاشوراء
بين الرّجال والنساء، والعبيد الأحرار، والبلّغ وغير البُلّغ
أنه لا فرق في استحباب الزيارة المبحوث عنها بين الرجال والنساء والأحرار والعبيد ، لأصالة الاشتراك.
وهل يطرد الاستحباب في غير البالغ؟
الأظهر القول به.
إلّا أن يقال : بالانصراف إلى البالغ ، بل الأوجه القول بهذا المقال.
لكن نقول : إنّه يمكن دعوى القطع بعدم الفرق ، بل لا إشكال في القطع بعدم الفرق ، بل على هذا المنوال الحال في سائر المستحبات.
[التنبيه] التاسع عشر :
في استبعاد العقل ترتّب المثوبات الموعودة
على زيارة عاشوراء في حقّ القريب
إنّه ربّما تتوحش النفس ويستبعد العقل ترتّب المثوبات الموعودة في باب القريب ، كما ذكر في رواية «كامل الزيارة» تارة من ثواب ألفي ألف حجّة ، وألفي ألف عمرة ، وألفي ألف غزوة ، وثواب حجّة وعمرة وغزوة كثواب من حج واعتمر وغزى مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومع الأئمّة الراشدين.
وما ذكر فيها أخرى من ثواب ألف ألف حجّة ، وألف ألف عمرة ، وألف ألف غزوة كلّها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وثواب مصيبة كل نبيٍّ ورسولٍ وصديق وشهيدٍ مات أو قتل منذ خلق الله الدنيا إلى أن تقوم الساعة.
وما ذكر فيها ثالثة من ثواب ألف ألف حسنة ، ومحو ألف ألف سيئة ، ورفع مائة ألف ألف درجة ، والكون كمن استشهد مع سيّد الشهداء عليه السلام حتى يشارك معهم في درجاتهم ولا يعرف إلّا في الشهداء الذين استشهدوا معه وكتابة ثواب زيارة كلّ نبي ورسول وزيارة كلّ من زار سيّد الشهداء عليه السلام منذ يوم قتل صلوات الله عليه.
وكذا ما ذكر في رواية «المصباح» تارة من كتابة مائة مائة ألف درجة ، والكون كمن استشهد مع سيّد الشهداء عليه السلام حتى يشارك معهم في درجاتهم ولا يعرف إلّا في الشهداء الذين استشهدوا معه ، وكتابة ثواب كل نبي وكلّ رسول وزيارة كلّ من زار سيّد الشهداء عليه السلام منذ يوم قتل ، وما ذكر فيها أخرى من ثواب ألفي حجّة وألفي عمرة وألفي غزوة وثواب كل حجّة وعمرة كثواب من حجّ واعتمر وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومع الأئمّة الراشدين عليهم الصّلاة والسّلام.
وما ذكر فيها ثالثة من كتابة مائة ألف ألف درجة والكون كمن استشهد مع الحسين عليه السلام حتى يدرك في درجاتهم لا يعرف إلّا في الشهداء الذين استشهدوا معه وكتابة ثواب زيارة كل نبي وكل رسول وزيارة كلّ من زار الحسين عليه السلام مُنذ يوم قُتل عليه السلام ، بل على ذلك المنوال الحال فيما ذكر في رواية محمّد بن المشهدي في باب الجزاء من قبول الزيارة وشكر السعي ووصول السّلام وقضاء الحاجة بالغة ما بلغت والفوز بالجنّة والعتق من النار وغير ذلك مما ذكر في تلك الرواية ، وإن كان التوحّش والاستبعاد مما ذكر في تلك الرواية أقلّ ، إذ قبول الزيارة وقضاء الحاجة ووصول السّلام وأمثالها ليس مما يتوحش منه النفس وتستبعده ، نعم الفوز بالجنة مثلاً تتوحش منه النفس وتستبعده.
أقول : إنّ التوحّش والاستبعاد يطرّد في جميع المثوبات الجليلة الكثيرة الموعودة في الأخبار على الأعمال الخفيفة القليلة في كثير من الموارد ، وهذا من مشكلات الشريعة ، نظير مسألة الطّينة(١) .
__________________
(١) هذا منه إشارة إلى أخبار الطينة الواردة في بيان طينة المؤمن وطينة الكافر ، وقد وردت في هذه المسألة أخبار كثيرة تصل إلى حدّ الاستفاضة ، بل يمكن القول ببلوغها التواتر المعنوي ولا أقلّ من التواتر الإجمالي ، فقد عقد لها الشيخ الكليني رحمه الله في اُصول الكافي باباً مستقلاً أسماه بـ (باب طينة المؤمن والكافر) ، وضمّنه مجموعة من الأخبار ، فراجع اُصول الكافي : ٢: ٣.
كما عقد لها العلّامة المجلسي رحمه الله في بحاره باباً أسماه بـ (باب طينة المؤمن وخروجه من الكافر ، وبالعكس) ، وضمّنه عدداً كبيراً من الأخبار ، فراجع بحار الأنوار : ٦٤: ٧٧.
وقد أشار إلى هذه الأخبار العلّامة الطباطبائي في الميزان ، وقال ما نصّه ـ ولِنعم ما قال ـ: «ويناسب المقام عدّة من أخبار الطينة ، كما رواه في البحار عن جابر بن عبدالله ، قال : «قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله : أوّل شيء خلق الله ما هو؟
فقال : نور نبيّك يا جابر ، خلقه الله ثمّ خلق منه كلّ خير الخ»
بل حكى الفاضل التقي المجلسي قدس سره في شرح مشيخة الفقيه عن شيخنا البهائي الحكم بطرح الأخبار المذكورة ، حيث إنه حكى عنه أنه قال في الدرس : «إنا نعلم قطعاً إن أمثال هذه الأخبار كاذبة ، فإنه ورد أنّ ثواب إطعام المؤمن ألف ألف حجة ، فحينئذٍ لايبقى للحجّة مقدار».
إلا أن الفاضل المذكور حكى أنه ذكر لشيخنا البهائي أنه لا يمكن إنكار أمثال هذه الأخبار ، فإنها متواترة معنىً ، قال : وقلت أنتم تروون أنّ ضربة عليّ عليه السلام أفضل من عبادة الثقلين إلى يوم القيامة وتعتقدونه ، ولا شك أنّ ذلك بسبب علوّ شأنه عليه السلام ، بل كل فعل من أفعاله كذلك ، وكذلك كلّ واحد من الأئمّة صلوات الله عليهم بالنظر إلى غيرهم فأيّ استبعاد في أن يكون ثواب خلّص أوليائهم كذلك ، كما وقع في إطعام المسكين واليتيم والأسير ، وهذه المثوبات العظيمة وكانت فضة الخادمة فيهم ، مع أنه فرق بين الثواب الاستحقاقي والتفضّلي.
قال : فاستحسن كلامي ولم يتكلّم بما كان يتكلّم قبله.
لكن فيما ذكره الفاضل المشار إليه مجال المقال ، ويمكن أن يقال : إنّ العقل لا يستبعد في المقام ترتّب المثوبات المذكورة على الزيارة لأنّه من باب الجزاء على ما تحمله سيّد الشهداء عليه السلام في سبيل الله وحراسته الدين بنفسه وماله وعياله بما تقاسر الألسن والأقلام عن تقريره وتحريره.
__________________
«أقول : والأخبار في هذه المعاني كثيرة متظافرة ، وأنت إذا أجلت نظرة التأمّل والإمعان فيها وجدتها شواهد على ما قدّمناه ، وسيجئ شطر من الكلام في بعضها. وإيّاك أن ترمى أمثال هذه الأحاديث الشريفة المأثورة عن معادن العلم ومنابع الحكمة بأنّها من اختلاقات المتصوّفة أوهامهم ، فللخلقة أسرار ، وهو ذا العلماء من طبقات أقوام الإنسان لا يألون جهداً في البحث عن أسرار الطبيعة منذ أخذ البشر في الانتشار ، وكلّما لاح لهم معلوم واحد بان لهم مجاهيل كثيرة ، وهي عالم الطبيعة أضيق العوالم وأخسّها ، فما ظنّك بما ورائها ، وهي عوالم النور والسعة» ـ الميزان : ١: ١٢١.
ولنعم ما حكى عنه رُوحي وروح العالمين له الفداء :
تركتُ الناس كلا في هواكا |
وأيتمت العيال لكي أراكا |
|
وإن قطّعتني في الحبّ إربا |
لما حنّ الفؤاد إلى سواكا |
نعم يستبعد العقل ترتّب المثوبات المذكورة في باب الأعمال القليلة في سائر الموارد ، ويرشد إلى ما ذكرنا أنّه ربّما يتحمّل شخص شدّة في المراحل العادية خدمة لشخص والشخّص الثاني يبذل أموالاً كثيرة مجاناً لكلّ واحد من أقربائه وأحبّائه بملاحظة ما تحمله الشخص الأوّل من الشدّة.
ويمكن أن يقال : إنّه لو بذل عبد من عبيد السّلطان جميع ما أمكنه وتمكن منه وإن كان قليلاً فأبذل السلطان سلطنته إليه لا يضائق عنه العقل ولا يحكم بردائه ما صنعه وركاكته ، بل يحكم بحسنه ، بل يحكم بكونه في غاية حسن المكافاة وقد بذل سيّد الشهداء روحي وروح العالمين له الفداء جميع ما تمكّن منه في سبيل الله مع شرافة نفسه وشرافة أنفس سائر الشهداء الذين شهدوا عنده ولاسيّما أقربائه وكذا شرافة أهله الأسرآء بعده روحي وروح العالمين له الفداء أو بشرافة الشخص ودنوها يختلف حال عمله من حيث العلوّ والدنوّ ، وبهذا يختلف أجر عمله كما أنّه يختلف الخضوع عند الله سُبحانه باختلاف عز الشخص وذلّة فقد يكون شيء من العزيز موجباً للطف الله سبحانه إليه دون الذّليل لكون الشيء المشار إليه موجباً لشدّة الخضوع من العزيز دون الذليل ، والمثوبات المذكورة من باب المكافاة لما بذله سيّد الشهداء روحي وروح العالمين له الفداء قليل من كثير ما يتمكّن منه الله سبحانه مع سعة رحمته ووفور فضله ومما يختلف به حال المكافاة سعة أمر الشخص وضيقه ، فمقتضى ما ذكرنا في باب العبد والسلطان ، كفاية نفس بذل سيّد الشهداء روحي وروح العالمين له الفداء ما بذله في رفع الاستبعاد وبملاحظة غاية شرافة نفس سيّد الشهداء وشرافة أهله وعياله وكذا ساير الشهداء وسعة رحمة الله سبحانه غاية السعة
يزيد رفع الاستبعاد ويتناقص الاستبعاد.
لكن هذا الوجه كالوجه السابق يختصّ بالمثوبات المذكورة في باب زيارة سيّد الشهداء روحي وروح العالمين له الفداء.
ويمكن أن يقال : أنه قد جرت العادة واستمرة سيرة الناس على إعطاء الكثير بالقليل ، مثلاً ربما يعطي الشخص خمسين درهماً بإهداء ما يكون قيمته عشرين درهماً ويغمض عن خمسين درهماً لو كانا ديّانا باهداء ما ذكر ، ومن قبيل الأخير حال أرباب الدّيوان ، حيث إنّ الشخص المستولي على الوظيفة الدّيوانية ربما يقصد إمساك مبلغ وباهداء ما دون المبلغ بدرجات يتجاوز عما قصده ويعطي ما قصد إمساكه ، والسرّ فيه أنّ النفس تقبل ويتطرّق عليه الحبّ بواسطة الإهداء ، ولما أقبلت وتطرق عليها الحبّ ، فيقدم على السّماحة والإغماض على حبّ الإقبال وتطرق الحبّ ، وهذا الوجه لا يختص بمثوبات زيارة سيّد الشهداء روحي وروح العالمين له الفداء ، بل يعم غيرها.
إلاّ أن يقال : إنّ الوجه المذكور لا بأس به فيمن يكون إعطائه على حسب اقتضاء الميل ، وأما الله سبحانه فلمّا كان إعطائه وإغماضه على حسب اقتضاء الحكمة ومقدار استعداد العمل فيما لا يكون الأمر فيه من باب التفضّل ، بل ليس التفضّل إلّا على وجه يقتضيه الحكمة ، فلا يتجه الوجه المذكور في المثوبات المذكورة من جانبه سُبحانه بإزاء الأعمال القليلة.
ويمكن أن يقال : إنّ مقتضى الإستقراء في القرآن ورود ثلاثة أقسام من العذاب على قوم لوط : الصّيحة ، وانقلاب الأرض ، وتماطر الأحجار ، مع كفاية واحدٍ منها في تحقّق الهلاك ، وكل ما يمكن أن يكون مصلحة في تعدد العذاب ، يتأتّى نظيره في باب المثوبات الجزيلة على الأعمال القليلة ، فالتوقف في باب تلك المثوبات أولى من طرحها ، والحكم بكذب تلك الأخبار كما هو مقتضى ما تقدم
حكايته عن شيخنا البهائي.
تذييلٌ :
في اشتراط المثوبات المشار إليها بتطرّق البكاء حال الزّيارة
مقتضى ما رواه في كامل الزيارة و «المصباح» إناطة المثوبات المشار إليها بتطرق البكاء حال الزيارة ، لقول أبي جعفر عليه السلام : «حتى يظلّ عنده باكياً » ، بعد قوله عليه السلام : «من زار الحسين عليه السلام يوم عاشوراء » بأن حضر قبره الشريف ، ويكفي في البكاء صدق الاسم للاطلاق.
إلّا أن يقال : إنه لا يكفي مجرّد صدق الاسم ، بل لابدّ من شمول الاطلاق ، كما هو الحال في سائر موارد الاطلاق ، فلو كان من القلّة على مقدار لا يشمله الاطلاق لا يكفي ، وإن تأتّى صدق الاسم.
وإن قلت : إنّ مقتضى معنى : «ظلّ باكياً » هو استغراق النهار بالبكاء ، كما يقال : «ظلّ زيد متفكّراً» ، والمعنى المداومة على التفكّر في النهار ، نظير : «إن بات زيد متفكّراً» ، بمعنى المداوة على التفكّر ، قضيته أنّ معناه البيتوتة بالتفكّر ، ومعناه المداومة في الليل على التفكّر.
قلت : إنّ «ظلّ» وإن يشتمل في إتيان الفعل بالنهار على وجه الاستيعاب ، كما إن (بات) يستعمل في اتيان الفعل في الليل على وجه الاستيعاب ، بل ظاهر «القاموس» و «المجمع» : كون «ظلّ» حقيقة فيما ذكر ، لكنه قد يستعمل بمعنى صار مجرّداً عن الزمان ، نحو قوله تعالى : ( ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً ) (١) ، والأمر في المقام من قبيل الأخير بلا شبهة ، كيف واشتراط البكاء في تمام يوم عاشوراء في
__________________
(١) النحل ١٦: ٥٨.
ترتب الثواب على الزيارة التي تتحصّل في قليل من الزمان مقطوع العدم ، بل استغراق اليوم بالبكاء غير ممكن ، كيف واستغراق تمام الزيارة بالبكاء نادر ، بل نظير الاشتراط المذكور مفقود الأثر في الشريعة.
ثمّ إنّ العلّامة المجلسي قدس سره قال في «زاد المعاد» ترجمة لقوله عليه السلام : «حتى يظل باكياً» (يا كريان شود) بالمثناة التحتانية وهو من سهو القلم ، والصّواب (تا كريان شود) بالمثناة الفوقانية ، كما في «تحفة الزائر».
[التنبيه] العشرون :
في استحباب زيارة عاشوراء في غير يوم عاشوراء
أنه لا إشكال في اطّراد استحباب الزيارة المتقدّمة في غير يوم عاشوراء من سائر الأّيام ، لقول أبي جعفر عليه السلام في آخر ما رواه علقمة على مارواه في «كامل الزيارة » : «يا علقمة ، إن استطعت أن تزوره في كلّ يوم بهذه الزيارة من دهرك فافعل ، فلك ثواب جميع ذلك إن شاء الله » ، ويرشد إليه قول الصادق عليه السلام لصفوان على مارواه في «المصباح» ، وكذا محمّد بن المشهدي : «يا صفوان ، إذا حدث لك إلى الله حاجة ، فزر بهذه الزيارة من حيث كنت ».
إلّا أن يقال : إنّ العموم فيه من حيث المكان لا الزمان ، والعموم من جهة لا يستلزم العموم من جهة أخرى.
إلّا أن يقال : إنّ مقتضى أمثال تلك القضية الشرطية تكرّر الجزاء بتكرّر الشرط ، ومتقضاه اطّراد الاستحباب في عموم الأزمان فضلاً عن الأيّام ، ويظهر الحال بملاحظة ما حرّرناه في منطوق القضية الشرطية في باب مفهوم الشرط في الأصول ، ويرشد إليه أيضاً قول الصادق عليه السلام لصفوان : «يا صفوان ، تعاهد هذه الزيارة » ؛ إذ الظاهر كون الغرض من التعاهد(١) المداومة ، نظير قوله ـ نقلاً ـ : «إذا رأيتم الرجل »
__________________
(١) قال في المصباح : «تعهّدته : حفظته. قال ابن فارس : ولا يقال : تعاهدته ؛ لأنّ التفاعل لا يكون إلّا من اثنين. وقال الفارابي : تعهّدته أصلح من تعاهدته» ، انتهى. وفي بعض الأخبار : «تعاهدوا عباد الله نعمه بإصلاح أنفسكم تزدادوا يقيناً » ، وقد وقع التعاهد أيضاً في طائفة من كلمات الفقهاء في باب استحباب تعاهد النعال في المساجد ، وفرّع الشهيد الثاني الإيراد بأنّ التعهّد أفصح ، إلّا أنّ التعهّد في الطائفة المشار إليها من باب المتابعة للرواية. منه رحمه الله.
يتعاهد صلاته ».
وكذا قول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الله بن أبي يعفور المعروفة(١) : «ويكون منه التعاهد للصّلوات الخمس إذا واظب عليهنّ وحفظ مواقيتهنّ بحضور جماعة من المسلمين ».
وكذا قوله عليه السلام في تلك الصحيحة : «مواظباً على الصّلوات ، متعاهداً لأوقاتها في مُصلاّه » ، بل مقتضى هاتين الفقرتين مرادفة التعاهد والمداومة.
أمّا الثانية فالأمر فيها ظاهر ، وأمّا الأولى فلأن الظاهر أنّ قوله عليه السلام : «إذا واظب عليهن » من باب التفسير ، بمعنى أن التعاهد إنما يتحقّق في صورة المواظبة لا من باب تقييد التعاهد بالمواظبة ، ويلزمه كون التعاهد أعم من المواظبة.
إلّا أن يقال : إنّ غاية الأمر كون الغرض المداومة على الزيارة في جميع أيّام عاشوراء لا المداومة في جميع الأيّام ، بل نقول هذا هو الظاهر ، إذ الظاهر من بيان الثواب والجزاء بعد ذلك هو كونه لأصل الزيارة في يوم عاشوراء ، وأما لو كان الغرض المداومة في جميع الأيّام فالثواب إمّا لنفس المداومة أو كلّ يوم على تقدير ، وعلى هذا يلزم الإغماض عن الثواب على الأصل وهو الزيارة في يوم عاشوراء والتعرض للثواب على الفرع وهو المداومة على الزيارة.
إلّّا أن يقال : إنّ الغرض الثواب على كل يوم ولو بدون المداومة فيتأتى ذكر الثواب على الأصل ، ولا يلزم الإغماض عن الأصل والتعرّض للفرع.
لكن نقول : إنّه على هذا يلزم ذكر الأصل بتبع ذكر الفرع وفي ضمن ذكر الفرع ، وهو بعيد.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧:٣٩١ ، الباب ٤١ من أبواب الشهادات ، الحديث ١.
تذييلان
أحدهما : في تبديل بعض الكلمات على تقدير إيقاع زيارة عاشوراء في غير عاشوراء
أنّ مقتضى كلام العلّامة المجلسي قدس سره في «تحفة الزائر» و «زاد المعاد» أنه على تقدير إيقاع الزيارة المتقدّمة في غير يوم عاشوراء يلزم أن يقال مكان «هذا» فيما يقال :اللّهُمَّ إِنّ هٰذا يَوْمٌ تَبَرَّكَتْ بِهِ بَنُو اُمَيَّةَ (يوم قتل الحسين عليه السلام) ، قال : «وﭼﻮﻥ در حيدث تجويز كردن اين زيارت در هر وقت وارد شده أست اﮔﺮ در غير روز عاشوراء كند بجاى : اللّهمّ إنّ هذا يوم تبرّكت به بنو أمية يوم قتل الحسين ﺑﮕﻮﻳﺪ.
وسبق إلى تلك المقالة في «البحار» ، قال : «قوله عليه السلام : «أن تزوره في كل يوم» ، يستلزم الرخصة في تغيير عبارة الزيارة كأن يقول: اللّهُمَّ إِنَّ يَوْمَ قَتْلِ الْحُسَيْنِ يَوْمٌ تَبَرَّكَتْ بِهِ.
ومقتضى ما ذكر أن يقال موضع «هذا» «في» هذا يوم فرحت به آل زياد (ويوم قتل الحسين) فكان على العلّامة المشار إليه الإشارة إليه.
اللّهمّ إلاّ أن يقال : إنّه بعد تبديل «هذا» بـ (يوم قتل الحسين) في : «اللّهمّ إنّ هذا يوم» بكون «هذا» في «وهذا يوم فرحت» إشارة إلى يوم قتل الحسين ، ولا حاجة إلى التبديل(١) ، ولعلّ هذا كان عذر العلّامة المشار إليه في عدم الإشارة
__________________
(١) وعن بعض المنع عن التبديل المذكور بملاحظة لزوم البدعة ، وليس بشيء ، وقد حكى السيّد السند شارح الصحيفة السجّاديّة في شرح قول مولانا سيّد السجّاد عليه آلاف التحيّة من ربّ العباد إلى يوم التناد في الدعاء عند ختم القرآن : «اللّهمّ إنّك أنزلته على نبيّك محمّد صلى الله عليه وآله مجملاً، وألهمته علم عجائبه مكملاً، وورثنا علمه مفسّراً، وفضّلتنا على مَن جهل علمه، وقوّيتنا عليه لترفعنا فوق مَن لم يطق حمله » ينبغي تبديل قوله عليه السلام :»
إلى ما ذكر.
إلّا أن يقال : إنّ «هذا» موضوع للإشارة إلى القريب و (يوم قتل الحسين) المبدل إليه بعيد بالإضافة إلى «هذا» في «وهذا يوم» فلايصحّ الإشارة به إليه ، فلابدّ من التبديل.
اللّهمّ إلاّ أن يقال : إنّ المصرّح به في النحو كثرة استعمال (ذا) و (ذاك) و (ذلك) في كل من القريب والبعيد والمتوسّط.
إلّا أن الكلام في كونه حقيقة أو مجازاً.
وعلى أيّ حال ، فلا بأس باستعمال «هذا» في البعيد ، ولا حاجة إلى التبديل بلا إشكال ، ومقتضى ما ذكر أيضاً تبديل «أتيتكما» في دعاء الوداع في : «يا أمير المؤمنين ، ويا أبا عبد الله ، أتيتكما زائراً» بـ: (توجّهت إليكما).
بل الشيخ قدس سره في «التهذيب» في باب من بعدت شقته وتعذّر عليه قصد المشاهد بعد أن روى عن أحمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عمّن رواه ، قال : «قال أبو عبدالله عليه السلام : إذا بعدت بأحدكم الشقّة ، ونأت به الدار ، فليعلو أعلى منزله ، وليصلّ ركعتين ، وليومِ بالسلام إلى قبورنا ، فإنّ ذلك يصل إلينا ».
وقال قدس سره : «وتسلّم على الأئمّة عليهم السلام من بعيد كما تسلّم عليهم من قريب ، غير إنّك لا يصحّ أن نقول : أتيتك زائراً ، بل تقول في موضعه : قصدت بقلبي زائراً ؛ إذ عجزت من حضور مشهدك ووجّهت إليك سلامي لعلمي بأنّه يبلغك صلّى الله
__________________
«وورثنا علمه» وقوله عليه السلام : «وفضّلتنا» ونحو ذلك من الألفاظ بألفاظ تناسب حالة الداعي.
وحكى السيّد السند الشارح المشار إليه : بأنّ الأوْلى تبديل الضمير فقط ، فيقال في قوله : «إنّك أنزلته على نبيّك مجملاً» ثمّ إعادة سائر الضمائر إليه ، وأن يقال : «وفضّلتهم وقوّيتهم عليه لترفعهم»؛ لما في ذلك من إبقاء المعنى على أصله. منه رحمه الله.
عليك ، فاشفع لي عند ربّك عزّ وجلّ ، وتدعو بما أحببت»(١) .
ومقتضى صريحة القول بالتبديل ، بناء على كون العبارة المذكورة من الشيخ قدس سره ، كما جرى عليه في «البحار» و «تحفة الزائر» و «زاد المعاد»(٢) ، وهو الأظهر ، لأنه روى تلك الرواية في «الكافي» عن عدّة من الأصحاب ، عن أحمد بن محمّد ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٦: ١٠٣ ، باب من بعدت شقته وتعذّر عليه قصد المشاهد ، الحديث ١.
(٢) ونظير ما صنعه الشيخ من تبديل بعض أجزاء الحديث بناءً على كون العبارة المذكورة من الشيخ ما صنعه الصدوق في كتاب الحجّ في باب القِران بين الأسابيع ، حيث قال : «وقال زرارة : ربّما طفت مع أبي جعفر عليه السلام وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ثمّ ينصرف ويصلّي الركعات ستّاً ، وكلّما قرن الرجل بين طواف النافلة صلّى لكلّ اسبوع ركعتين» ، فإنّ قوله : «وكلّما قرن ...» من الصدوق وليس من الرواية ، كما نصّ عليه المحدّث القاشاني في حاشية الوافي ، وفي حاشية الفقيه تعليقاً على الكلام المذكور (من كلام المصنّف).
وفي الأخبار ما يدلّ عليه.
وروي في التهذيب في باب الوكالات عن محمّد بن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثمّ مات ، هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها؟
قال عليه السلام :إنّ كانت وكّلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه، وإن لم تكن وكّلته فلها ذلك، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك، إلّا أن تكون حينئذٍ صبيّة في حجره، فيجوز لأبيها أن يقبض عنها، ومتى طلّقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضاً ، ليس له أن يدع كلّه، وذلك قول الله عزّ وجلّ: ( إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) [البقرة ٢: ٢٣٧]» ، يعني الأب ، والذي توكّله المرأة وتولّيه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما».
قال العلّامة المجلسي في بعض تعليقات التهذيب : «الظاهر أنّه يعني قوله : ومتى طلّقها قبل الدخول ، من كلام الصدوق ، وإن كان مضمون الروايات ، وظنّ الشيخ أنّه تتمّة الخبر ، ويحتمل أن يكون من كلام الشيخ على بعد. منه رحمه الله.
عن ابن أبي عمير ، عمّن رواه ، قال : «قال أبو عبد الله عليه السلام الخ» ، والمروي فيه خال عن العبارة المذكورة.
وكذا رواه في «كامل الزيارة» عن أبيه ، عن سعد ومحمّد بن يحيي ، عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير ، عمّن رواه ، قال : «قال أبو عبد الله عليه السلام» ، والمروي فيه خال أيضاً عن العبارة المذكورة(١) .
إلّا أن يقال : إن خلو رواية «الكافي» و «كامل الزيارة» عن العبارة المذكورة لا ينافي اشتمال ما رواه في «التهذيب» ، لعدم رواية الشيخ عن «الكافي» ولا عن «كامل الزيارة» وعدم دخول ابن قولويه وهو مقدم على الشيخ في مشيخته في هذا الحديث ، حيث إنّ ما رواه عن أحمد بن محمّد بن عيسى فقد رواه على ما ذكره في المشيخة عن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطار ، عن أبيه محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، بل ابن قولويه غير داخل في مشيخة الشيخ رأساً.
لكنّه مدفوع : بكفاية اتّحاد السند من أحمد بن محمّد بن عيسى ، حيث إنّ أحمد بن محمّد في رواية «الكافي» هو أحمد بن محمّد بن عيسى لرواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير كتب مائة رجل من رجال الصادق عليه السلام ، على ما في «الفهرست» ، وفي سند «كامل الزيارة» تصريح بابن عيسى ، مضافاً إلى شهادة نفس تلك العبارة من جهة التعبير فيها بالأئمة عليهم السلام والتسليم عليهم بخروجها عن الرواية.
فقد بان صحة المؤاخذة على الكفعمي في بعض حواشي كتابه(٢) ، وكذا على
__________________
(١) وقد تقدّم ذكر هذه الرواية في التنبيه السادس.
(٢) الظاهر أنّه في حواشي كتابه المصباح المعروف بجنّة الأمان الواقية وجنّة الإيمان الباقية.
المحدّث الحرّ في «الوسائل»(١) ، حيث إنه روى كل منهما العبارة المذكورة تتمّة للرواية
وبالجملة : لا ينبغي الارتياب في لزوم تبديل الإشارة الأولى ، أعني الإشارة في «اللّهمّ إنّ هذا يوم» بـ «يوم قتل الحسين» ، ولا خفاء في أولوية التبديل المذكور في الإشارة الثانية ، أعني الإشارة في «وهذا يوم» ، ولا ينبغي الارتياب أيضاً في لزوم تبديل «أتيتكما» بـ «توجّهت إليكما».
وإن قلت : إنّه لا إشكال في جواز الإتيان بالإشارة الأولى في يوم عاشوراء في أمثال هذه الأعصار ، مع أن يوم عاشوراء في أمثال هذه الأعصار ليس ممّا تبرك به بنو اُميّة ، بل المُتبرّكُ به إنّما هو اليوم الأوّل ، أعني اليوم الذي قتل فيه سيّد الشهداء عليه السلام رُوحي وروح العالمين له الفداء ، أو الأيّام التي وقعت في أعصار بني أميّة من يوم عاشوراء ، فلا يخرج الأمر عن التعبّد ، فلا بأس بالإتيان بالإشارة الأولى في غير يوم عاشوراء أيضاً ، وبما ذكر يظهر حال الإشارة الثانية.
قلت : إن المقصود بالإشارة الأولى لو كان الزيادة في أمثال هذه الأعصار هو شبيه اليوم ، أعني اليوم الذي وقع فيه بالخصوص قتل سيّد الشهداء روحي ورُوح العالمين له الفداء ، غاية الأمر لزوم التجوّز ، بناء على كون هذا موضوعاً للإشارة إلى ما يصحّ الإشارة الحسّية إليه وجواز التجوّز لما ادّعيت من أنّه لا إشكال في جواز الإتيان بتلك الإشارة في أمثال هذه الأعصار ، وليس الأمر في الباب من باب التعبّد بلا ارتياب ، وبما ذكر يظهر حال الإشارة الثانية.
وإن قلت : إنّ مقتضى تجويز تلك الزيارة في كل يوم هو جواز البناء في الإشارة وغيرها على حالهما.
__________________
(١) فراجع وسائل الشيعة : ١٤: ٥٧٧ ، الباب ٩٥ من أبواب المزار وما يناسبه ، الحديث ٣.
قلت : إنّه لابدّ من تقييد التجويز بحكم العقل والتقييد أمر سهل.
وبعد هذا أقول : أنّه يمكن أن يكون هذا لو كانت الزيارة في غير يوم عاشوراء إشارة إلى يوم عاشوراء المعهود في الذّهن الذي وقع فيه بالخصوص قتل سيّد الشهداء روحي وروح العالمين له الفداء ، كما سمعت فيما لو كان الزيارة في يوم عاشوراء ، غاية الأمر لزوم التجوّز اللاّزم فيما لو كان الزيارة في يوم عاشوراء أيضاً.
ونظير التبديل المتعيّن في المقام أنّه يتعيّن تبديل : «وإلى جدّكم بعث الروح الأمين» في الزيارة الجامعة الكبيرة ، بأن يقال : «وإلى أخيك» ، كما ذكره في «التهذيب» و «الفقيه» و «تحفة الزائر» و «زاد المعاد».
ويمكن أن يقال : إنّ المناسب بل اللاّزم الاقتصار في دعاء الوداع في : «يا أمير المؤمنين ، ويا أبا عبد الله ، عليكما منّي سلام الله» إلى : «يا أبا عبد الله» ، وتبدل : «عليكما» بـ«عليك» ؛ إذ الوداع لما كان من الصادق عليه السلام عند رأس أمير المؤمنين عليه السلام ، فكان ما ذكر من دعاء الوداع مناسباً ، وأما الزائر من البعيد فلا يناسب منه ذلك ، والمناسب بل اللاّزم في حقه ما ذكرنا من الإقتصار والتبديل.
وبما ذكرنا يظهر الحال في : «من زيارتكما» و: «بينكما» ، وكذا الحال في : «يا أمير المؤمنين ، ويا أبا عبد الله ، أتيتكما» ، حيث إنّ المناسب الاقتصار على : «يا أبا عبد الله» ، وتبديل : «أتيتكما» بـ«توجّهت إليكما» كما مرّ.
وكذا الحال في : «ربّكما» و «متوجّهاً إليه بكما ومستشفعاً بكما» ، وكذا الحال في : «بشفاعتكما» ، وكذا الحال في : «أستودعكما الله» ، وكذا الحال في : «انصرفت يا سيّدي يا أمير المؤمنين ومولاي ، وأنت يا أبا عبد الله» ، وكذا الحال في : «يا سيديَّ وسلامي عليكما» ، وكذا الحال في : «بحقّكما» ، وكذا الحال في : «يا سادتي ، رغبت إليكما وإلى زيارتكما بعد أن زهد فيكما وفي زيارتكما» ، وكذا الحال في : «وما أمّلت في زيارتكما».
في أنّ دعاء الوداع مشتمل على أمور ثلاثة :
وبالجملة دعاء الوداع بيَّنَ أموراً :
أوّلها : التضرّع والدّعاء ، وهو من الصدر المصدّر بألفاظ الجلالة(١) إلي قوله : «يا أمير المؤمنين ، ويا أبا عبد الله ، عليكما منّي سلام الله».
وربّما قيل : إنه الذي ورد الحث عليه في رواية صفوان ، بحيث يؤتى به في كلّ زمان ومكان.
ثانيها : السّلام على الإمامين مع الدّعاء ، وهو ممّا بعد قوله المختتم به الأوّل أعني قوله عليه السلام : «يا أمير المؤمنين ، ويا أبا عبد الله ، عليكما منّي سلام الله» إلى قوله عليه السلام : «يا أمير المؤمنين ، ويا أبا عبد الله ، أتيتكما زائراً ومتوسّلاً إلى الله ربّي وربّكما ، ومتوجّهاً إليه بكما ، ومستشفعاً بكما إلى الله في حاجتي هذه».
ثالثها : الاستشفاع من الإمامين في قضاء الحوائج ، وهو ممّا بعد قوله المختتم به الثاني إلى قوله : «انصرفت يا سيدي يا أمير المؤمنين ومولاي ، وأنت يا أبا عبد الله» ، ولا يخفى عليك أنّ المناسب للوداع لمن لم يكن عند رأس أمير المؤمنين عليه السلام هو الاقتصار على الأمر الأوّل ويشهد شهادة كاملة على ابتناء الوداع على كونه من عند رأس أمير المؤمنين عليه السلام ما تقدّم من رواية محمّد بن المشهدي ، حيث قال الصادق عليه السلام : «ثمّ أوم إلى الحسين عليه السلام ، وقل : السّلام عليك يا أبا عبد الله ، السّلام عليك يابن رسول الله ».
ثمّ قال عليه السلام : «ثم تلتفت إلى أمير المؤمنين عليه السلام وتقول : السّلام عليك يا أمير المؤمنين ، والسّلام على أبي عبد الله الحسين ».
__________________
(١) مراده بذلك قوله : «يا الله ، يا الله ، يا الله».
فيما يدلّ على عدم جواز التغيير في الدعاء
وبعد ما مرّ أقول : أنّه قد روى الكليني في أواخر «أصول الكافي» في باب القول عند الإصباح والإمساء بسنده عن العلاء بن كامل ، قال : «سمعت أبا عبد الله عليه السلام بقول : ( وّاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ ) (١) ،عند المساء لا إلـٰه إلّا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيى ويميت ويميت ويحيى ، وهو على كلّ شيء قدير.
قال : قلت بيده الخير.
قال :إنّ بيده الخير ، ولكن قل : كما أقول لك ...»(٢) .
وروى الصدوق في «كمال الدين» في باب ما روى عن الصادق عليه السلام من النصّ على القائم عليه السلام ، وذكر غيبته ، وأنه الثاني عشر ، بسنده عن عبد الله بن سنان ، قال : «قال أبو عبد الله صلوات الله عليه :ستصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يرى ، ولا إمام هدى ، ولا ينجو منها إلّا من دعا بدعاء الغريق.
قلت : وكيف دعاء الغريق؟
قال :تقول : يا الله ، يا رحمن ، يا رحيم ، يا مقلّب القلوب ، ثبّت قلبي على دينك
فقلت : يا الله ، يا مقلّب القلوب والأبصار ، ثبّت قلبي على دينك.
فقال :إنّ الله عزّ وجلّ مُقلّب القلوب والأبصار ، لكن قل كما أقول : يا مُقلّب القلوب ، ثبّت قلبي على دينك »(٣) .
__________________
(١) الأعراف ٧: ٢٠٥.
(٢) اُصول الكافي :٢: ٣٨٣/١٧.
(٣) كمال الدين وتمام النعمة : ٣٥١ ، الباب ٣٣ ما أخبر به الصادق عليه السلام من وقوع الغيبة ، الحديث ٤٩.
ومقتضى الخبرين تطرّق النّقص بالزيادة ، وعدم جواز التعدّي عما ورد فمقتضاهما عدم جواز التعدّي عن الوارد في عموم الموارد ، فلا يتّجه التبديلات المتقدّمة ، وعلى هذا المنوال الحال فيما كان يختلج بالبال من أنّ المناسب أن يقال في دعاء كميل بعد قوله عليه السلام : «إِلهي وَربِّي مَنْ لي غَيْرُكَ أَسْأَلُهُ كَشْفَ ضُرِّي ، وَالنَّظَرَ في أَمْرِي » (ومن يكشف ضرّاً ، أو ينظر في أمرٍ غيرك) ، وكذا ما اختلج بالبال من أنّ المناسب أن يقال بعد قوله عليه السلام : في بعض المواضع : «كلما كبر سنّي زاد معصيتي» ، (بل كلّما تنفّست نفساً زادت معصيتي).
وكذا ما ذكره بعض الأعلام من أنّ المناسب أن يقال في دعاء أبي حمزة المعروف في طيّ قوله عليه السلام : «ما لي كُلَّمَا قُلْتُ قَدْ صَلُحَتْ سَرِيرَتي ، وَقَرُبَ مِنْ مَجالِسِ التَّوّابِينَ مَجْلِسي ، عَرَضَتْ لي بَلِيَّةٌ أَزالَتْ قَدَمَيَّ وَحالَتْ بَيْني وَبَيْنَ خِدْمَتِكَ الخ» ، (أو لعلّك رأيتني غير قابل لخدمتك فبعدتني؟) ، وكذا ما كان قوي في النظر من جواز أن يقرأ دعاء كميل في يوم جمعة مثلاً مع تبدل الليلة في قوله عليه السلام : «أَنْ تَهَبَ لي في هٰذِهِ اللَّيْلَةِ » باليوم.
وربّما يقال : إنّ المنع عن الزيادة في الخبرين المتقدّمين من جهة قصد التوظيف ، فلايمانع عن الزيادة والتغيير بدون قصد التوظيف.
وفيه : إنّه لو أمضى الإمام الزيادة لما تطرق هذا المحذور ، فمقتضى المنع أنه ليس من جهة قصد التوظيف ، مع أنّ الحمل على قصد التوظيف خلاف الظاهر.
لكن نقول : إنه لا خلاص ولا مناص عن التغييرات المتقدّمة ، وأما التغيير الغير اللازم أو الزيادة الغير اللازمة فالكلام فيه غير مربوط بالمقام ولا حاجة فيه إلى الكلام.
ثم إنّ تبديل الإشارة الأولى بـ (يوم قتل الحسين) إنّما يتعيّن في رواية «المصباح» ، وأما ما في «كامل الزيارة» وهو : «اللّهُمَّ اِنَّ هٰذا يَوْمٌ تَنْزِلُ فيهِ اللَّعْنَةُ
عَلىٰ آلِ زِيادٍ ، وَآلِ اُمَيَّةَ الخ».
فمقتضى صريح كلام العلّامة المجلسي قدس سره في «البحار» عدم الحاجة فيه إلى التبديل ، لكن الأولى والأحوط التبديل ، كيف ونزول اللعنة في كل يوم خال عن الدليل
بقي أنّ العلّامة المجلسي قدس سره ذكر في «زاد المعاد» بعد الفراغ عن زيارة أمير المؤمنين عليه السلام في اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأوّل ، أعني يوم مولد النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه يقصد البعيد بهذا الحرم وهذا الضّريح روضة أمير المؤمنين عليه السلام وضريحه ، ومقتضاه جواز أن يقصد بهذا اليوم هنا يوم عاشوراء لو كان الزيارة في غير يوم عاشوراء.
لكن الظاهر بل بلا إشكال أن المدار فيما ذكره على استعمال مجموع هذا الحرم وهذا الضّريح في روضة أمير المؤمنين عليه السلام وضريحه ، وهو ظاهر الفساد.
وذكر العلّامة المشار إليه في «زاد المعاد» أيضاً بعد ذكر حديث حنان بن سدير الوارد في زيارة سيّد الشهداء عليه السلام ، والمشتمل على فقرات صريحة في الوراثة المقصود بها الإمامة ، أعني : «السَّلَامُ يا وارِثَ آدَمَ صِفْوَةِ اللهِ ، وَوارِثَ نُوحٍ نَبِيِّ اللهِ ، وَوارِثَ إِبْراهيمَ خَليلِ اللهِ ، وَوارِثَ موسىٰ كَليمِ اللهِ ، وَوارِثَ عيسىٰ رُوحِ اللهِ وَكَلِمَتِهِ ، وَوارِثَ مُحَمَّدٍ حَبيبِ اللهِ وَنَبيِّهِ وَرَسولِهِ ، وَوارِثَ عَلِيٍّ أميرِ الْمُؤْمِنينَ » ، وبعد ترجمة ما في الحديث المذكور من أنّه يزار علي بن الحسين بمثل الزيارة المذكورة أنّه عند زيارة عليّ بن الحسين يقول الزائر بعدُ بدل : «يا وارث» في جميع موارده : «يابن وارث» أو يقصد من الوراثة غير الخلافة ، لعدم إمامة علي بن الحسين ، ولعلّ مقتضاه التخيير في المقام بين تبدل هذا اليوم بيوم قتل الحسين وقصد يوم قتل الحسين من هذا اليوم.
ويظهر الحال فيه بما مر ، ومع هذا ما تكرر في الزيارة المذكورة هو : «وارث»
لا «يا وارث» ، ومقتضى كلامه تكرّر «يا وارث» ، حيث إنّه ذكر تبديل «يا وارث» في موارده ، فكان الصواب أن يذكر تبديل «وارث» في موارده لا تبدل «يا وارث» في موارده.
[التذييل الثاني] ثانيهما : في استحباب زيارة عاشوراء في جميع أجزاء
سائر الأيّام غير يوم عاشوراء والليالي
أنّه ربّما قيل باطّراد استحباب الزيارة في جميع أجزاء سائر الأيام غير يوم عاشوراء ، بملاحظة قول أبي جعفر عليه السلام لعلقمة ، كما مرّ : «إن استطعت أن تزوره في كل يوم بهذه الزيارة من دهرك فافعل فلك ثواب جميع ذلك » ، بل باطراد الاستحباب في الليالي بملاحظة أنّ اليوم يطلق غالباً على المعنى الشامل للنهار والليل ، والمقصود به عموم اليوم في الأقوال المشار إليها للّيل بواسطة غلبة إطلاق اليوم على مجموع الليل والنهار.
أقول : إنّ مقتضى ما تقدّم من اشتراط الزيارة بكونها قرب الزوال عدم عموم التشريع لغير قرب الزوال من يوم عاشوراء سابقاً أو لاحقاً فضلاً عن غير يوم عاشوراء فضلاً عن الليل.
نعم ، لا بأس بايقاعها في غير قرب الزوال سابقاً أو لاحقاً في يوم عاشوراء أو غير يوم عاشوراء من سائر الأيام أو الليل بعد الاطّلاع على الاشتراط ، لعدم ما في البدعة والتشريع وليس مانع آخر في البين ، لكن لو قصد التشريع جهلاً من دون اجتهاد ولاتقليد بل من خيال من عند النفس أو قصده من باب اجتهاد فاسد أو تقليد غير معتبر ، يتأتّى الحرمة لتطرق البدعة.
وأمّا الاستدلال المذكور على اطّراد الاستحباب في الليل.
فهو مدفوع : بأن الظاهر من اليوم هو ما يقابل الليل وليس غلبة استعماله في
الأعمّ بعد تسليم الغلبة إلى حدٍ يوجب الإجمال فضلاً عن الظهور في الأعمّ ، مضافاً إلى ما تقدم من اشتراط الايقاع بقرب الزوال.
لكن نقول : إنّ ما ذكرناه من حد الاشتراط إنّما يتمّ بناء على التقييد في المندوبات ، كما هو الأظهر ، وإلّا فيطّرد الاستحباب ، كما أنّه لو قلنا بالتسامح في المندوبات حتى في الاحتمال الغير المعتدّ به المخالف للظاهر ، يتأتى اطّراد الاستحباب على القول بالتقييد أيضاً ، كما لو قلنا بعدم التّسامح في المندوبات ، كما هو الأظهر أو بعدم التسامح في الاحتمال المخالف للظاهر ، فلا مجال للاستحباب بعد التقييد ، وبما ذكر يظهر كفاية احتمال استعمال اليوم في الأعم بناء على التسامح في المندوبات حتى في الاحتمال المخالف للظاهر ، لكن الاظهر كما سمعت عدم التسامح في المندوبات فضلاً عن صورة مخالفة الاحتمال للظاهر ، وبما سمعت يظهر حال الايقاع في اليوم واللّيل بالايقاع في آخر اليوم وأول الليل أو آخر الليل وأوّل اليوم بالايقاع فيما قبل طلوع الفجر وما بعده بناء على كون ما بين الطّلوعين من اليوم أو فيما بين الطّلوعين وما بعد طلوع الشمس بناء على كون ما بين الطلوعين من الليل ، ثم إنّه على تقدير جواز الايقاع في الليل لابد من تبدل ما تقدم لزوم تبديله في صورة الايقاع في غير يوم عاشوراء ، وكذا تبدل : «هذا اليوم» في : «اللّهُمَّ إِنّي أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ في هذَا الْيَوْمِ » في آخر الزيارة : «هذه الليلة» أو «بهذا الوقت» مثلاً.
[التنبيه] الحادي والعشرون :
في اختلاف رواية «كامل الزيارة» و «المصباح»
في متن زيارة عاشوراء في ثلاثة وثلاثين وجهاً
أن رواية «كامل الزيارة» و «المصباح» تختلفان في متن الزيارة المبحوث عنها في أمور :
[الوجه] الأوّل : أنّ في «كامل الزيارة» : «السَّلَامُ عَلَيْكَ يا خِيَرَةَ اللهِ وَابْنَ خِيرَتِهِ » بعد : «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَابْنَ رَسُولِ اللهِ » وليس ذلك في «المصباح» ، وعلى هذا حال «تحفة الزائر» و «زاد المعاد».
[الوجه] الثاني : أنّ في «كامل الزيارة» : «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَابْنَ فاطِمَةَ سَيِّدَةِ النِّساءِ ». وفي «المصباح» : «يَابْنَ فاطِمَةَ الزَّهْراءِ سَيِّدَةِ نِساءِ الْعالَمينَ ». وعن بعض النسخ : «سَيِّدَةِ نِساءِ الْعالَمينَ ». وفي «تحفة الزائر»:«يَابْنَ فاطِمَةَ سَيِّدَةِ نِساءِ الْعالَمينَ ». وفي «زاد المعاد» : «يَابْنَ فاطِمَةَ الزَّهْراءِ سَيِّدَةِ النِّساء ».
[الوجه] الثالث : أنّ في «كامل الزيارة» : «لَقَدْ عَظُمَتِ الْمُصيبَةُ بِكَ عَلَيْنا وَعَلىٰٰ جَميعِ أَهْلِ السَّمٰواتِ ». وفي «المصباح» : «لَقَدْ عَظُمَتِ الرَّزِيَّةُ ، وَجَلَّتْ وعَظُمَتْ الْمصيبَةُ بِكَ عَلَيْنا وَعَلىٰ جَميعِ أَهْلِ الْإِسْلامِ ، وَجَلَّتْ وَعَظُمَتْ مُصيبَتُكَ في السَّمٰواتِ عَلىٰ جَميعِ أَهلِ السَّمٰواتِ ». وفي «زاد المعاد» : «لَقَدْ عَظُمَتِ الرَّزِيَّةُ ، وَجَلَّتِ الْمُصيبَةُ » إلى آخر ما في «المصباح». لكن عن بعض نسخ «تحفة الزائر» : «عَظُمَتِ » مكان «جَلَّتِ ».
[الوجه] الرابع : أنّ في «المصباح» قبل : «يا أَبا عَبْدِاللهِ ، بَرِئْتُ إِلى اللهِ وَإِلَيْكُمْ مِنْهُمْ وَمِنْ أَشْياعِهِمْ وَأَتْباعِهِمْ وَأَوْلِيائِهِمْ ». وليس هذا في «كامل الزيارة». وعلى هذا حال «تحفة الزائر» و «زاد المعاد».
[الوجه] الخامس : أنّ في «كامل الزيارة» : «فَلَعَنَ اللهُ آلَ زِيادٍ » بالفاء. وفي «المصباح» بالواو. وعلى هذا حال «تحفة الزائر» وكذا «زاد المعاد» نقلاً ، لكن ما عندي من نسخة «زاد المعاد» بإسقاط : «فَلَعَنَ اللهُ آلَ زِيادٍ وَآلَ مَرْوانَ » ، لكنّ الظاهر أنّه من باب سقط الكتاب.
[الوجه] السادس : أنّ في «كامل الزيارة» : «وَتَهَيَّأَتْ لِقِتالِكَ ». وفي «المصباح» الموجود عندي : «تَهَيَّأَتْ وَتَنَقَّبَتْ ». وعن بعض نسخه تقديم الثاني على الأوّل ، وعن بعض آخر من نسخه : «تَنَقَّبَتْ » مكان «تَهَيَّأَتْ ». وفي «تحفة الزائر» و «زاد المعاد» :تَنَقَّبَتْ وَتَهَيَّأَتْ.
[الوجه] السابع : أنّ في «كامل الزيارة» قبل : «بِأَبي أَنْتَ يا أَبا عَبْدِاللهِ ». وليس هذا في «المصباح». وعلى هذا حال «تحفة الزائر» و «زاد المعاد».
[الوجه] الثامن : أنّ في «كامل الزيارة» : «أَنْ يُكْرِمَني وَيَرْزُقَني ». وفي «المصباح»(١) : «وَأَكْرَمَني بِكَ أَنْ يَرْزُقَني ». وعلى هذا حال «تحفة الزائر» و «زاد المعاد».
[الوجه] التاسع : أنّ في «كامل الزيارة» : «مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ». وفي «المصباح» : «مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ ». وعلى هذا حال «تحفة الزائر» و «زاد المعاد».
__________________
(١) قوله : «وفي المصباح» وعن بعض نسخ المصباح : «وأكرمني أن يرزقني». منه رحمه الله.
[الوجه] العاشر : أنّ في «كامل الزيارة» ـ على ما حكى ـ: «اللّهُمَّ الجْعَلْني وَجيهاً بِالْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلامُ عِنْدَكَ ». وفي «المصباح» : «اللّهُمَّ اجْعَلْني عِنْدَكَ وَجيهاً » ، أي بتأخير «وَجيهاً ». وعلى هذا حال «تحفة الزائر» و «زاد المعاد». لكن نسخة عندي من «كامل الزيارة» ليس فيها «عِنْدَكَ ».
[الوجه] الحادي عشر : أنّ في «كامل الزيارة»(١) : «وَبِالْبَراءةِ مِمَّنْ أَسَّسَ أَساسَ الْجَورِ وَبَنَىٰ عَلَيْهِ بُنْيانَهُ ، وَأَجْرى ظُلْمَهُ وَجَوْرَهُ عَلَيْكُمْ ». وفي «المصباح» : «وَبِالْبَراءَةِ مِمَّنْ أَسَّسَ ذلِكَ وَبَنىٰ عَلَيْهِ بُنْيانَهُ ، وَجَرىٰ في ظُلْمِهِ وَجَوْرِهِ عَلَيْكُمْ ».
وفي «تحفة الزائر» و «وزاد المعاد» : «وَبِالْبَراءَةِ مِمَّنْ أَسَّسَ أَساسَ ذلِكَ وَبَنىٰ عَلَيْهِ بُنْيانَهُ ، وَجَرىٰ في ظُلْمِهِ وَجَوْرِهِ عَلَيْكُمْ ». وقد أجاد من قال(٢) : «وما أدرى من أين له ذلك».
[الوجه] الثاني عشر : أنّ في «كامل الزيارة» : «وَمِنَ النّاصِبينَ لَكُمُ الْحَرْبَ ». في «المصباح» : «وَالنّاصِبينَ » بإسقاط حرف الجرّ. وعلى هذا حال «تحفة الزائر» و «زاد المعاد».
[الوجه] الثالث عشر : أنّ في «المصباح» : «وَبِالْبَراءَةِ مِنْ أَشْياعِهِمْ ». وعلى هذا حال «تحفة الزائر» و «زاد المعاد» ، وفي «كامل الزيارة» : «وَالْبَراءَةِ » بإسقاط
__________________
(١) قوله : «في كامل الزيارة وبالبراءة» على ما نقله في بحار الأنوار ، ولكنّه في نسخة عندي من كامل الزيارة : «بموالاتك والبراءة ممّن قاتلك» ، وفي المصباح : «وبالبراءة» ، وعلى هذا حال تحفة الزائر وزاد المعاد. منه رحمه الله.
(٢) قوله : «وقد أجاد من قال : الظاهر أنّ ما في تحفة الزائر وزاد المعاد مأخوذ من المصباح ، كما هو الحال في سائر أجزاء المتن ، وإنّما زيد لفظ «أساس» سهواً. منه رحمه الله.
حرف الجر.
[الوجه] الرابع عشر : أنّ في «كامل الزيارة» : «وَأَن يَرْزُقَني طَلَبَ ثارِكُمْ ». وفي «المصباح» : «طَلَبَ ثاري» ، وعلى هذا حال «تحفة الزائر» و «زاد المعاد»
[الوجه] الخامس عشر : أنّ في «كامل الزيارة» : «مَعَ إِمامٍ مَهْديٍّ ناطِقٍ لَكُمْ ». وفي «المصباح»(١) : «مَعَ إِمامٍ مَهْديٍّ ظاهِرٍ ناطِقٍ بِالْحَقِّ مِنْكُمْ ».
وفي «تحفة الزائر» و «زاد المعاد» : «مَعَ إِمامٍ مَهْديٍّ ظاهِرٍ ناطِقٍ مِنْكُمْ ».
[الوجه] السادس عشر : أنّ في كامل الزيارة : «أَقُولُ إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ،يا لَها مِنْ مُصيبَةٍ » ، وليس هذا في «المصباح» ، وفيه : «مُصاباً بِمُصيبَتِهِ ». وعلى هذا حال «تحفة الزائر» و «زاد المعاد» ، وعن بعض نسخ «تحفة الزائر» : «يا لَها» بين لفظي «المصيبة».
[الوجه] السابع عشر : أنّ في كامل الزيارة : «وَفي جَميعِ السَّماواتِ وَالْأَرَضين ». وفي «المصباح» : «وَفي جَميعِ أَهْلِ السَّمٰواتِ وَالْأَرْضِ ». وعلى هذا حال «تحفة الزائر» و «زاد المعاد» ، وعن بعض نسخ «المصباح» : إسقاط الأهل.
[الوجه] الثامن عشر : أنّ في «كامل الزيارة» :«اللّهُمَّ اِنَّ هٰذا يَوْمٌ تَنْزِلُ فيهِ اللَّعْنَةُ عَلىٰ آلِ زِيادٍ ، وَآلِ اُمَيَّةَ ». وفي «المصباح» : «اللّهُمَّ إِنَّ هٰذا يَوْمٌ تَبَرَّكَتْ بِهِ بَنُو اُمَيَّةَ ». وعلى هذا حال «تحفة الزائر» و «زاد المعاد».
__________________
(١) قوله : «وفي المصباح مع إمام مهديّ» هذا على ما نقله في بحار الأنوار ، ولكن ما في نسخة عندي من المصباح على منوال تحفة الزائر وزاد المعاد. منه رحمه الله.
[الوجه] التاسع عشر : أنّ في كامل الزيارة : «عَلىٰ لِسانِ نَبِيِّكَ » ، وعلى هذا حال «تحفة الزائر» و «زاد المعاد». وفي «المصباح» : «عَلىٰ لِسانِكَ وَلِسانِ نَبِيِّكَ » ، وهو المحكي عن بعض نسخ «تحفة الزائر».
[الوجه] العشرون : أنّ في «كامل الزيارة» : «وَعَلىٰ يَزيدَ بْنَ مُعاوِيَةَ اللَّعْنَةُ أَبَدَ الْاَبِدينَ » وفي «المصباح» : «وَيَزيدَ بْنَ مُعاوِيَةَ ، عَلَيْهِمْ مِنْكَ اللَّعْنَةُ أَبَدَ الْاَبِدينَ ». وعلى هذا حال «تحفة الزائر» و «زاد المعاد».
[الوجه] الحادي والعشرون : أنّ في «كامل الزيارة» : «فَضاعِفْ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةَ أَبَداً ». وفي «المصباح» : «اللّهُمَّ فَضاعِفْ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَ مِنْكَ وَالْعَذابَ ». وعلى هذا حال «تحفة الزائر» و «زاد المعاد».
[الوجه] الثاني والعشرون : أنّ في «كامل الزيارة» : «وَبِاللَّعْنِ عَلَيْهِمْ ». وفي «المصباح» : «وَاللَّعْنَةِ عَلَيْهِمْ ». وعلى هذا حال «تحفة الزائر» و «زاد المعاد».
[الوجه] الثالث والعشرون : أنّ في كامل الزيارة : «وَأَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكَ ». وفي «المصباح» : «وَآلِ بَيْتِكَ ». وعلى هذا حال «تحفة الزائر» و «زاد المعاد».
[الوجه] الرابع والعشرون : أنّ في كامل الزيارة : «حارَبَتِ الْحُسَيْنَ ». وفي «المصباح» : «جاهَدَتِ الْحُسَيْنَ ». وعلى هذا حال «تحفة الزائر» و «زاد المعاد».
هذا وربّما يتوهّم : أنّ جاهدت من غلط الراوي أو الشيخ ، بملاحظة أنّ الجهاد هو المقاتلة مع الكفّار.
ويندفع : بأنّ الظاهر من الجهاد في لسان الفقهاء وإن كان هو المقاتلة مع الكفّار لو لم يكن هذا حقيقة في اصطلاحهم ، لكن بعد ثبوت الحقيقة الثانوية في لسان
الأئمّة ، فالمراد بالجهاد هنا هو المعنى اللغوي ، حيث إنّه لغة بمعنى مطلق المقاتلة مع العدوّ ، كما يرشد إليه ما ذكر في «القاموس» : من أنّ من «الجهاد بالكسر القتال مع العدوّ»(١) .
وإن قلت : إنّه على فرض ثبوت الحقيقة المتشرّعية لا مجال للحمل على المعني اللغوي.
قلت :
لا بأس بذلك ، كيف ولا يتجاوز الأمر عن التجوز بالنسبة إلى المعنى اللغوي ، مع أنّ الصّلاة قد استعملت في الدّعاء في قوله سبحانه في سورة التوبة؟
(
وَصَلَّ عَلَيْهِمْ
)
(٢)
ولم يقل أحد بمنافاته مع ثبوت الحقيقة الشرعية في الصّلاة.
ومع هذا أقول : إنّ غاية الأمر ثبوت الحقيقة الثانوية في لسان الأئمّة في لفظ الجهاد ، وأما قوله عليه السلام : «جاهدت» يمكن أن يكون من المجاهدة وهي بمعنى مطلق المقاتلة مع العدوّ ، كما هو مقتضى كلام صاحب القاموس ، ومنه مجاهدة النفس ، وإن كان هذا من باب المجاز ، بل لا محل ولا مجال لدعوى اختصاصها بالمقاتلة مع الكفار.
[الوجه] الخامس والعشرون : أنّ في كامل الزيارة : «وَبايَعَتْ » بالباء الموحّدة ، وعلى هذا حال «زاد المعاد». وفي «تحفة الزائر» : «وَبايَعَتْ وَتابَعَتْ » بالموحدّة والمثناة.
وفي «المصباح» : «وَتابَعَتْ » بالتاء المثنّاة من فوق.
[الوجه] السادس والعشرون : أنّ في «كامل الزيارة» : «عَلىٰ قَتْلِهِ وَقَتْلِ أَنْصارِهِ »
__________________
(١) القاموس المحيط : ١: ٥٨٨ ، مادة «جهد».
(٢) التوبة ٩ : ١٠٣.
وليس في «المصباح» : «وَقَتْلِ أَنْصارِهِ ». وعلى هذا حال «تحفة الزائر» و «زاد المعاد».
[الوجه] السابع والعشرون : أنّ في «كامل الزيارة» بعد : «حَلَّتْ بِفِنائِكَ وَأَناخَتْ بِرَحْلِكَ » ، وليس هذا في «المصباح». وعلى هذا حال «تحفة الزائر» و «زاد المعاد» ، وعن بعض نسخ «المصباح» : «وَأَناخَتْ بِحَرَمِكَ ».
[الوجه] الثامن والعشرون : أنّ في كامل الزيارة : «وَلَا يَجْعَلَهُ اللهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِن زِيارَتِكُمْ » على غيبة الفعل. وفي «المصباح» : «وَلَا جَعَلَهُ اللهُ ».
[الوجه] التاسع والعشرون : أنّ في «كامل الزيارة» : «وَأَصْحابِ الْحُسَينِ »
وفي «المصباح» : «وَعَلىٰ أَصْحابِ الْحُسَينِ » بزيادة حرف الجر. وعلى هذا حال «تحفة الزائر» و «زاد المعاد».
[الوجه] الثلاثون : أنّ في «كامل الزيارة» ـ بعد : «وَأَصْحابِ الْحُسَينِ » ـ : «صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعينَ » ، وليس هذا في «المصباح». وعلى هذا حال «تحفة الزائر» و «زاد المعاد».
[الوجه] الحادي والثلاثون : أنّ في «كامل الزيارة» : «اللّهُمَّ خُصَّ أَنْتَ أَوَّلَ ظالِم ظَلَمَ آلَ نَبِيِّكَ بِاللَّعْنِ ، ثُمَّ الْعَنْ أَعْداءَ آلِ مُحَمَّدٍ مِنَ الْأَوَّلينَ وَالْآخِرينَ ، اللّهُمَّ الْعَنْ يَزيدَ وَأَباهُ ، وَالْعَنْ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيادٍ وَآلَ مَرْوانَ وَبَني اُمَيَّةَ قاطِبَةً إِلىٰ يَوْمِ الْقِيامَةِ ». وفي «الصباح» : «اللّهُمَّ خُصَّ أَنْتَ أَوَّلَ ظالِمٍ بِاللَّعْنِ مِنّي ، وَابْدَأْ بِهِ أَوَّلاً ، ثُمَّ الْعَنِ الثّاني وَالثّالِثَ وَالرّابِعَ. اللّهُمَّ الْعَنْ يَزيدَ خامِساً ، وَالْعَنْ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيادٍ وَابْنَ مَرْجانَةَ وَعُمَرَ بْنَ سَعْدٍ وَشِمْراً وَآلَ أَبي سُفْيانَ وَآلَ زِيادٍ وَآلَ مَرْوانَ إِلىٰ يَوْمِ
الْقِيامَةِ ». وعلى هذا حال «تحفة الزائر» و «زاد المعاد» ، لكن فيهما : «ثُمَّ الثّاني ، ثُمَّ الثّالث ثُمَّ الرّابع ».
[الوجه] الثاني والثلاثون : أنّ في «المصباح» : «لَكَ عَلىٰ مُصابِهِمْ ». وعلى هذا حال «تحفة الزائر» و «زاد المعاد» ، وفي «كامل الزيارة» إسقاط ذلك.
[الوجه] الثالث والثلاثون : أنّ في «كامل الزيارة» : «عَلىٰ عَظيمِ رَزِيَّتي فِيهِمْ » ، وليس في «المصباح» كلمة : «فِيهِمْ ». وعلى هذا حال «تحفة الزائر» و «زاد المعاد».
[التنبيه] الثاني والعشرون :
في شرح طائفة تحتاج إلى الشرح
من فقرات زيارة عاشوراء وكذا دعاء الوداع
في شرح طائفة تحتاج إلى الشرح من فقرات الزيارة المتقدّمة وكذا الدعاء المتقدّم.
أما فقرات الزيارة فنقول :
قوله : «تَنَقَّبَتْ ».
أقول : إنّه قد احتمل الكفعمي أن يكون مأخوذاً من النقاب الذي للمرأة ، أي اشتملت بالآت الحرب ، كاشتمال المرأة بنقابها ، فيكون النقاب هنا استعاره ، وأن يكون مأخوذاً من النقبة وهو ثوب يشتمل به كالإزار ، وأن يكون المعني سارت في نقوب الأرض ، وهي طرقها الواحد نقب وهي المناقب أيضاً ، ومنه قوله تعالى : ( فَنَقَّبوا فِي الْبِلَادِ ) (١) ، أي طافوا وساروا في نقوبها أي طرقها ، قال :
لقدْ نقّبتُ في الآفاقِ حتى |
رضيتُ من الغنيمةِ بالايابِ(٢) |
واحتمل العلّامة المجلسي قدس سره في «البحار» : أنّه كان النقاب بينهم متعارفاًً عند الذّهاب إلى الحرب بل إلى مطلق الأسفار حذراً من أعدائهم لئلّا يعرفوهم ، فهذا إشارة إلى ذلك(٣) .
__________________
(١) ق ٥٠ : ٣٦.
(٢) مصباح الكفعمي : ٢: ٥٦٥ ، ذكر ذلك في الحاشية.
(٣) بحار الأنوار : ٩٨: ٣٠١ ، الباب الرابع والعشرون.
قوله : «يا ثارَ اللهِ وَابْنَ ثارِهِ ».
أقول : أنّ مقتضى صريح «المصباح»(١) أنّ الثأر بالهمزة ، وهو ظاهر «الصّحاح»(٢) و «القاموس»(٣) و «المجمع»(٤) ، لكنّه غير مأنوس ، والظاهر أنّ ما وقع في موارد الدّعاء(٥) بالألف لعله من باب التخفيف في الاستعمال ، وفي «القاموس» : «الثار : الدم ، والطلب به ، وقاتل حميمك»(٦) ، ومقتضى صريح الصحاح أن الثار يطلق على قاتل الحميم أيضاً ، كما في قول حرير :
قَتلوا أباكَ وثارُهُ لم يُقَتلِ
وكذا يطلق علي القاتل أيضاً ، كما يقال : «يا ثارات فلان» أي قتلة فلان(٧) ، وقال المطرزي نقلاً : وَأَدْرَكَ فُلانٌ ثارَهُ إذا قَتلتَ قاتَل حميمِهِ.
وأمتن كلام وقع في التفسير في المقام ما ذكره بعض الأعلام من أنّ الثار الدّم وطلب الدم ، والمراد هنا هو الأخير.
__________________
(١) المصباح المنير : ٨٨ ، مادة «ثور».
(٢) صحاح الجوهري : ٢: ٦٠٣ ، مادة «ثأر».
(٣) القاموس المحيط : ١: ٧١٢ ، مادّة «ثأر».
(٤) مجمع البحرين : ١: ٣٠٥ ، مادّة «ثأر».
(٥) وفي بعض الزيارات : «وَأَنَّكَ ثارُ اللهِ في أَرْضِهِ حَتّىٰ يَسْتثيرُ لَكَ مِنْ جَميعِ خَلْقِهِ » ، وفي بعض آخر : «إِنَّكَ ثارُ اللهِ في الْأَرْضِ وَابْنَ ثاره » ، وفي بعض ثالث : «وَإِنَّكَ ثارُ اللهِ في الْأَرْضِ ». منه رحمه الله.
(٦) القاموس المحيط : ١: ٧١٢ ، مادّة «ثأر».
(٧) صحاح الجوهري : ٢: ٦٠٣ ، مادّة «ثأر» ، وما نقله المصنّف هنا عنه بتصرّف غير مخلّ ، حيث إنّ الجوهري قال : «والثأر : الذي لا يبقى على شيء حتّى يدرك ثأره ، ويقال أيضاً : هو ثأره ، أي قاتل حميمه. قال جرير : قتلوا أباك وثأره لم يقتل ، وقولهم : يا ثارات فلان ، أي يا قتلة فلان.
وفي المقام يحتمل معنيين :
أحدهما : إنّك الذي يطلب الله بدمه من أعدائه ، وحينئذٍ يُقدّر مضاف للثار ، أي أهل ثار الله ، ويكون إضافة الثار إلى الله بمعنى «من» أي إنك أهل طلب الدّم من الله ، أي طلب الدّم الذي يكون الطلب ناشئاً منه سُبحانه وأنت أهلٌ لذلك الطلب الناشئ منه
وثانيهما : إنّك أهل طلب الدم بأمر الله سبحانه أو في سبيل الله ، وحينئذٍ أيضاً يقدّر «الأهل» ، ويكون إضافة الثار أما بمعنى «في» أي إنك أهل طلب الدم ، أي دم الشهداء في الله ، أي في سبيله حين الرجعة ، أو يكون بتقدير مضاف آخر ، أي إنّك أهل الثار بأمر الله في الرجعة(١) .
ولا يذهب عليك إنّ ما ذكره بأجمعه في إصلاح الحال بناء على كون المقصود بالثار هو طلب الدّم خلاف الظاهر ، ويرشد قوله : «أَنْ يَرْزُقَني طَلَبَ ثارِكَ » إلى كون الثار هنا بمعنى الدّم.
وإن استشهد المحقّق القمّي في جواب السؤال عن تلك الفقرة على كون الثار هنا بمعنى طلب الدّم وغرضه دلالة إظهار الطلب في قوله : «وَأَنْ يَرْزُقَني طَلَبَ ثارِكَ » على إضمار الطلب هاهنا ، وليس بشيء ، لكن لاينافي إرشاد المرشد المذكور وقوله : «وَأَنْ يَرْزُقَني طَلَبَ ثارِي » حيث إنه لا مجال لإضافة الثار إلى ياء المتكلم ، إلّا أن يكون الإضافة من باب المسامحة والغرض انتساب الطلب إلى المتكلّم.
ثم إنّ الظاهر أنّ المقصود بطلب الدّم هو القصاص ، وإلّا فتفسير المطرزي إدراك
__________________
(١) وهذا المعنى ذكره العلّامة المجلسي في بحار الأنوار بشكل مختصر ، بقوله : «الثأر ـ بالهمزة ـ الدم وطلب الدم ـ أي أنّك أهل ثار الله والذي يطلب الله بدمه من أعدائه ، أو هو الطالب بدمه ودماء أهل بيته بأمر الله في الرجعة» ـ بحار الأنوار : ٩٨: ١٥١.
الثار بقتل قاتل الحميم تفسير بالأخصّ ، لكن في «الصحاح» : «يقال : ثأرتك بكذا ، أي أدركت به ثاري منك»(١) ، ومقصوده كون الثار بأخذ الديّة.
بقي أنّه قد ذكر في المجمع : أنّ الثار الذي لا يبقى على شيء حتى يدرك ثاره ، واحتمل كون «يا ثارَ اللهِ وَابْنَ ثارِهِ » مصحّف «ثائر الله وابن ثائره »(٢) .
وأنت خبيرٌ بأنه لايصحّ المعنى في يا ثائر الله بدون التجشم ، إذ لولا الصحّة بدون التجشم فلا داعي إلى احتمال التصحيف ، اللهمّ إلّا أن يكون غرضه مجرّد استيفاء الاحتمال.
هذا وعن بعض النسخ في بعض زيارات(٣) سيّد الشهداء عليه السلام : «ثائر الله وابن ثائره»(٤) .
قوله : «وَالْوِتْرَ الْمَوْتُورَ ».
أقول : أما الوِتْرُ ففي «المصباح» : «الوِتْرُ : الفَرْد والذَّحْل بالكسر فيهما لتميم» ،
__________________
(١) صحاح الجوهري : ٢: ٦٠٣ ، مادّة «ثأر».
(٢) مجمع البحرين : ١: ٢٠٦ ، مادّة «ثأر». ولكن ما نقله المصنّف غير مطابق تماماً لما في الطبعة الحديثة التي نعتمد عليها ، حيث إنّه قال هنا : «والثائر : الذي لا يبقي على شيء حتّى يدرك ثأره ، وفي مخاطبة الإمام حين الزيارة : أشهد أنّك ثار الله وابن ثاره ، ولعلّه مصحّف من يا ثار الله وابن ثائره ، والله أعلم».
(٣) وهي الزيارة التي رواها الشيخ الكليني في فروع الكافي : ٤: ٥٧٥/٢.
(٤) روي في الفقيه عن عبدالله بن لطيف التفليسي ، عن رزين ، قال : قال أبو عبدالله عليه السلام: لمّا ضرب الحسين بن عليّ عليهما السلام بالسيف وسقط ، ابتدر ليقطع رأسه نادى منادٍ من بطنان العرش: أيّتها الاُمّة المتحيّرة الضالّة بعد نبيّها، لا وفّقكم الله لأضحى ولا فطر ».
وفي خبر آخر : «لصوم ولا فطر ».
قال : ثمّ قال أبو عبدالله عليه السلام : «فلا جرم والله ما وفّقوا ولا يفّقون حتّى يثور ثائر الحسين بن عليّ عليهما السلام ، وهو مولانا القائم عليه السلام ». منه رحمه الله.
وبفتحِ العددُ وكسرِ الذَّحْل لأهل العالية ، وبالعكس وهو فتح الذَّحْل وكسر العدد لأهل الحجاز ، وقُرِئَ في السبعة : «وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ »(١) بالكسر على لغة الحجاز وتميم ، وبالفتح في لغة غيرهم. قال : ويقال : وَتَرْتُ العددَ وَتْراً من باب وَعَدَ أفردتُهُ.
ثم قال : ومن باب وَعَدَ أيضاً نَقَصْتُهُ ، ومنهُ مَنْ فاتتهُ صلاةُ العصرِ ، فكأنّما وُتِرَ أهلَه ومالَه بنصبهما على المفعولية شُبِّه فِقدَانُ الأجرِ لأنهُ يُعَدُّ لِقَطْعِ المصاعِبِ ودفعِ الشدائِدِ بِفِقدانِ الأهلِ لأنهم يُعَدُّونَ لدفعِ ذلكَ ، فأقامَ الأهلَ مقامَ الأجرِ»(٢) .
وفي «نجد الفلاح في اختصار الصحاح»(٣) على ما حكاه الكفعمي في بعض حواشي كتابه : الوِتر بالكسر الفرد وبالفتح الذحل ، والحجازيّون الوَتِر بالفتح الفرد وبالكسر الذحل ، وتميم كسروهما(٤) .
وأمّا الموتور ففي «الصحاح» : «المَوتُورُ منْ قُتِلَ لهُ قَتِيلٌ فلمْ يُدْرِك بِدَمِهِ ، قال :
__________________
(١) الفجر ٨٩: ٣.
(٢) المصباح المنير : ٦٤٧ ، مادّة «وتر».
(٣) نجد الفلاج في مختصر الصحاح ، تأليف البياضي العاملي صاحب كتاب الصراط المستقيم.
(٤) مصباح الكفعمي : ١: ٣٩٦ ، إذا كان ما نقله المصنّف عن الكفعمي من المصباح ، فالظاهر أنّ المصنّف هنا سهى قلمه الشريف حيث نسب الكلام المذكور إلى حواشي الكتاب ، وهي في المتن ، وكذلك نقل عن الكفعمي أنّه حكي ذلك عن نجد الفلاح ولم نعثر على هذه الحكاية في موضع الكلام المذكور ، حيث إنّ الكفعمي في مصباحه ذكر ما نصّه : «الفرد الوتر هما بمعنى المنفرد بالربوبيّة وبالأمر دون خلقه ، والوتر ـ بالكسر ـ والفرد ـ بالفتح ـ الدحل. والحجازيّون عكسوا وتميم كسروا واو الوتر وذال الذحل.
وفي الحديث : «إن الله تعالى وتر يحبّ الوتر، فأوتروا » ، وقوله تعالى : ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) الفجر ٨٩: ٣ فيه أقوال ، ويمكن أن يكون المصنّف نقل ذلك عن الكفعمي في كتابه (فرج الكرب) أو في كتابه (البلد الأمين).
[وكذا] وَتَرَهُ حَقَّهُ أي نَقَصه ، وقوله تعالى : ( وَلَن يتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ) (١) ، أي لم ينتقصكم»(٢) .
وفي «المجمع» : «الموتور الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه ، ومنه الحديث : «أنا الموتور» ، أي صاحب الوتر الطالب بالثار(٣) .(٤)
والذي يقوى في النظر : أنّ الوتر لا معنى له غير الفرد ، وفي آخر صلوات أيام شهر رمضان : «اللّهُمَّ اطْلُبْ بِذَحْلِهِمْ وَوِتْرِهِمْ وَدمِائِهِمْ »(٥) ، والظاهر بل بلا إشكال أنّ الوتر فيه بمعنى الدم لإضافة الطلب إليه ، مضافاً إلى عطف الدماء عليه ، والظاهر أنّ الموتور من باب التأكيد ، نحو برد بارد وحجر محجور.
لكن يحتمل أن يكون المقصود به المقتول الغير المدرك بدمه ، إلاّ أنه من باب المجاز ، بناء على كونه حقيقة فيمن قتل له قتيل فلم يدرك بدمه ، إذ الموتور هو المقتول على الأوّل وصاحب المقتول على الثاني.
وبعد هذا أقول : إنّ في بعض الزيارات : «السَّلَامُ عَلَيْكَ يا وِتْرَ اللهِ وَابْنَ وِتْرِهِ »(٦) ، ولا مجال فيهما لكون المراد بالوتر الفرد ، والظاهر اتحاد المراد فيهما والمراد هنا.
__________________
(١) محمّد صلى الله عليه وآله ٤٧: ٣٥.
(٢) صحاح الجوهري : ١:٨٤٣ ، مادّة «وتر».
(٣) وقد روي في معاني الأخبار في باب معنى الموتور أهله وماله ، بسنده عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :«ما خدعوك عن شيء فلا يخدعوك في العصر، صلّها والشمس بيضاء نقيّة، فإنّ رسول الله (ص) قال: الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصر. قلت : وما الموتور أهله وماله؟ قال : لا يكون له أهل ولا مال في الجنّة ». منه رحمه الله.
(٤) مجمع البحرين : ٤: ٤٦٣ ، مادّة «وتر».
(٥) مصباح المتّهجد : ٦٢٢.
(٦) كامل الزيارة : ٤٠٦ ، الباب ٧٩ زيارات الحسين عليه السلام ، الحديث ٢٣.
إلّا أن يقال : إنّ المراد الفرد المتفرّد في الكمال في عصره ممن خلقه الله من نوع البشر.
قوله : «أَنْ يُبَلِّغَني الْمَقامَ الْمَحْمُودَ ».
أقول : قال في «البحار» : «مقام الشفاعة ، أي يؤهّلني لشفاعتكم ، أو ظهور إمام الحق وإعلا الدين وقمع الكافرين»(١) .
قوله : «مُصيبَةً ».
أقول : إنّه منصوب بفعل مقدّر ، نحو أذكر أو أعني ، كما يقال : «مكّة» لمن تأهّب للسفر ، أي تريد ، وأما ما في «كامل الزيارة» أعني : «يا لها مصيبةً» فنظيره : «يا لها نعمةً» في دعاء الخروج عن بيت الخلاء(٢) .
وقد حكى في «المجمع» في مادّة «لها» عن قائلٍ ، والقائل شيخنا البهائي في
__________________
(١) بحار الأنوار : ٩٨: ٣٠٢.
(٢) قوله : «في دعاء الخروج عن بيت خلاء» قد روي الدعاء المشار إليه في التهذيب عن أبي عبدالله عليه السلام ، عن آبائه ، عن عليّ عليه السلام أنّه كان إذا خرج من الخلاء قال : الحمد لله الذي رزقني لذّته ، وأخرج عنّي أذاه ، يا لها نعمة ـ ثلاثاً ـ.
وقد جرى شيخنا البهائي على كون قوله : «ثلاثاً» قيداً لقوله : «قال» ، فالغرض أنّ عليّاً عليه السلام كان يأتي بالدعاء ثلاثاً ، واحتمل كونه قيداً للجملة الأخيرة ، واحتملها في المجمع ، والظاهر أنّ الغرض من كونه قيداً للجملة الأخيرة هو أن يقال : «يا لها من نعمة» ثلاث مرّات.
كما جرى عليه غير واحد نقلاً عن البهائي على كون الغرض في قوله : «ثلاثاً» أن يقال : يا لها نعمة ثلاث مرّات ، ويحتمل أن يكون الغرض كونه قيداً للنعمة ، لكنّه خلاف الظاهر ، ويحتمل كونه قيداً للجملة الأخيرة ، وعلى هذا لا يمكن أن يكون الغرض أن يقال نعمة ثلاث مرّات ، ولعلّه مقالة غير واحد ، وقد سمعت المقالة ، ويمكن أن يكون الغرض التعجّب من النعمة الثلاث ، وهذا الوجه هو الأظهر في النظر في قوله : «ثلاثاً». منه رحمه الله.
مشرقه : «أنّ اللام في «يا لها» [نعمة] لام الاختصاص دخلت هنا للتعجّب والضمير يرجع إلى النعمة المذكورة سابقاً أو إلى ما دلّ عليه المقام من النعمة ونصب نعمة على التميّز نحو : «جاءني زيدٌ فيا له رجلاً»(١) .
فعلى ما ذكر يكون اللام للتعجّب نحو : «يا للماء» و «يا للغيث» و «يا لك رجلاً عالماً» ، ويكون الضمير في «لها» راجعاً إلى المصيبة المذكورة سابقاً أو المصيبة المستفادة من المقام ، نحو ولأبويه فيكون المرجع متقدماً حكماً و «من مصيبة» من باب التميّز ، نحو : «رطل من الزّيت» لكن لم يتقدّم النعمة مرجعاً للضمير المجرور في الدعاء المذكور ولم يذكره شيخنا البهائي والإرجاع إلى النعمة المستفادة من المقام مع كون التميّز هي النعمة غير مناسب.
إلّا أن يقال : إنّ النعمة المرجوع إليها هي النعمة الخاصّة والأمر بمنزلة أن يقال لهذا الرجل «رجلاً» ولا بأس به.
وبما ذكر يظهر الحال في المقام.
قوله :وَابْنَ مَرْجانَةَ.
أقول : قال في «المجمع» : «وابن مرجانة عبيد الله بن زياد لعنه الله»(٢) .
وعن الطبرسي في «أماليه» : «أنّ ابن مرجانة هو عبيد الله بن زياد ، وزياد أبوه ومرجانة إحدى جدّات زياد».
وقال الكفعمي في حاشية «المصباح» : «ابن زياد هو ابن مرجانة ، وإنما أعيد ذكره ثانياً تنبيها على عظم كفره وتناهي فجوره ومُظاهرته لعنه الله على سبّ أهل بيت النبوّة وسفك دمائهم ، وهذا يسمّى في علم البديع ذكر الخاص مع العامّ وهو أن
__________________
(١) مجمع البحرين : ٤: ١٤٧ ، مادّة «ل ﻫ ي».
(٢) مجمع البحرين : ٤ : ١٨٨ ، مادّة «مرج».
يذكر المتكلّّم شيئاً عاماً ثم يخصّ بعض أفراده بالذكر ثانياً إما لزيادة بغيه وفجوره كما قلنا في ابن زياد ، وإما للتنبيه على فضله وشرفه كقوله تعالى : ( مَنْ كَانَ عَدُوّاً للِّهِ وَملَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ) (١) ، فاعاد سبحانه ذكر جبرئيل وميكائيل بعد ذكر الملائكة تنبيهاً على فضلهما ، وكذا قوله تعالى : ( فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ) (٢) ، وإنّما عطف النخل والرمّان على الفاكهة وإن كانا منها بياناً لفضلهما كأنّهما لمزيّتهما في الفضل جنسان آخران»(٣) ، انتهى.
ولا يذهب عليك أنّ ما ذكره الكفعمي من كون الأمر من باب ذكر الخاصّ بعد العام مبني على كون ابن مرجانة معطوفاً على ابن زياد بملاحظة تعدّد أبناء زياد وعموم ابن زياد لهم وانحصار ابن مرجانة في عبيد الله ، وإلّا فمفهوم ابن زياد له جهة اختصاص من حيث التقييد بزياد وجهة عموم لكونه أعمّ من ابن مرجانة وغيره ، ويتأتى نظيره في ابن مرجانة فبين المفهومين عموم وخصوص من وجه ، لكن يمكن أن يكون ابن مرجانة معطوفاً على ابن زياد كما هو مقتضى سوق عطف عمر بن سعد على عبيد الله وكذا عطف آل مروان وآل زياد على عبيد الله بناءً على كون كلّ من المعطوف في المعطوف المتعدّد معطوفاً على المعطوف عليه الأوّل ، كما حكاه شيخنا البهائي في بعض كلماته عن محقّقي النحاة لا كون المعطوف الأوّل معطوفاً على ما عطف عليه والمعطوف الثاني معطوفاً على المعطوف الأوّل وهكذا.
وأما فقرات دعاء الوداع فنقول :
قوله : «وَيا مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَيَّ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ».
__________________
(١) البقرة ٢: ٩٨.
(٢) الرحمن ٥٥: ٦٨.
(٣) مصباح الكفعمي : ٢: ٥٦٧.
قال في «الصحاح» : «حبل الوريد عرق في العنق»(١) .
وفي «القاموس» : «الوريدان عرقان في العنق يخالط الإنسان في جميع أعضائه»(٢) ، وحكي القول بكونه «عرق الحلق»(٣) ، والقول بكونه «عرقاً متعلقاً بالقلب يعني أقرب إليه من قلبه»(٤) ، وحكي في معني الآية القول بكون المعنى «نحن أعلم به ممّن كان منه بمنزلة حبل الوريد في القرب» ، والقول بكون المعنى «نحن أملك به من حبل وريده مع استيلائه عليه وقربه منه» ، والقول بكون المعنى «نحن أقرب إليه بالإدراك من حبل الوريد لو كان مدركاً»(٥) .
وقال البيضاوي : «أي ونحن أعلم بحاله ممن كان أقرب إليه من حبل الوريد تجوّز بقرب الذات لقرب العلم لأنه موجبه ، وحبل الوريد مثلٌ في القرب ، قال : والموت أرخى لي من الوريد والحبل العرق وإضافته للبيان ، والوريدان عرقان مكتنفان بصفحتي العنق في مقدّمها متّصلان بالوتين يردان من الرأس إليه ، وقيل سمي وريد ؛ لأن الرّوح يردان من الرأس ، وقيل سمّي وريد لأن الروح يرد إليه»(٦) ، انتهى.
__________________
(١) صحاح الجوهري : ٤: ١٦٦٤ ، مادّة «حبل».
(٢) ما ذكره في القاموس : ١: ٦٤٧ ، مادة «الورد» الوريدان عرقان في العنق ج أوردة ، ويظهر أنّ قلم المصنّف سهى هنا وخلط بين ما ذكره صاحب القاموس وبين ما ذكره الطبرسي في مجمع البيان : ٦: ٢٣٩ في سورة ق ، حيث إنّ الثاني ذكر في بيان معنى قوله تعالى : ( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِن حَبْلِ الْوَرِيدِ ) من حبل الوريد وهو عرق يتفرّق في البدن يخالط الإنسان في جميع أعضائه.
(٣) حكاه الطبرسي في مجمع البيان : ٦: ٢٣٩ ، عن ابن عبّاس ومجاهد.
(٤) حكاه الطبرسي في مجمع البيان : ٦: ٢٣٩ ، عن الحسن.
(٥) هذه الأقوال الثلاثة الأخيرة نسبها إلى القيل في مجمع البيان : ٦: ٢٣٩.
(٦) تفسير البيضاوي : ٥: ٢٢٦ ، في تفسير قوله تعالى : ( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِن حَبْلِ الْوَرِيدِ ) ق ٥٠: ١٦
ولو جعل المعنى الأعلميّة بالحال ممّن كان يقرب قرب حبل الوريد ، كما هو مقتضى أوّل الأقوال التي ذكرها الطبرسي لكان أوجه ، وفي «البحار» : وفي «نسبة الأقربية إليه يعني حبل الوريد إشارة إلى جهة العلية»(١) .
قوله : «وَيا مَنْ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ».
قد ذكر في معناه وجوه :
أحدها : أنّه سبحانه يقلب القلوب إلى ما لا يريده الإنسان ، كما قال أمير المؤمنين : «عرفت الله بفسخ العزائم».
وفي بعض الأدعية : «يا مُقَلِّبَ الْقُلوبِ » ففيه تنبيه على أن الله سبحانه مُطلع على مكنونات القلب بما عسى أن يغفل عنه صاحبها ، والظاهر أنّ هذا المعنى لا يتمشى إلّا بأن يكون الغرض أنه سبحانه يحول بين أعضاء المرء وجوارحه وقلبه بأن يؤثر القلب في الجوارح على مقتضى ميله ، ولايمكن هذا إلّا بصرف القلب عن ميله ، لكون القلب سلطان البدن والجوارح ، فجوارحه واعضائه غير متمكّنة من مخالفة ميله إلاّ بتحوّل ميله.
ثانيها : أنّه يحول بين المرء وانتفاعه أو انتفاع غيره بقلبه بالموت ، ففيه حث وتحريص علي المبادرة على الطاعة.
ثالثها : أنّه سبحانه أقرب إليه من قلبه ، نظير أنه سبحانه أقرب إليه من حبل الوريد ، فإنّ الحائل بين الشيء وغيره أقرب إلى الشيء من غيره.
رابعها : أنه سبحانه أعلم بما في قلب المرء من نفسه.
وأنت خبير بما فيه من شدّة خلاف الظاهر.
خامسها : أنّه سبحانه يكتم على المرء ما في قلبه وينسبه للمصالح.
__________________
(١) بحار الأنوار : ٩٨: ٣٠٢.
وهذا مثل سابقه في شدة مخالفة الظاهر.
سادسها : أنه سبحانه يحول أن يستيقن القلب حقيقة الباطل.
وهذا أيضاً شديد المخالفة للظاهر ، مضافاً إلى تيقن كثير من الناس بحقيقة الباطل.
وقد روى بعضَ الوجوه المذكورة بعضُ الأخبارِ.
ثمّ إنّ في دعاء الوداع فقرات أخرى أمرها سهل إلّا أنها تحتاج إلى شرح قليل فنقول
قوله : «وَيا مَنْ هُوَ بِالْمَنْظَرِ الْأعْلىٰ ، وَبِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ».
يشتمل على كنايتين عن علو قدره وظهور أمره.
قوله : «خائِنَةَ الْأَعْيُنِ ».
مصدر بمعنى الخيانة على زنة الفاعلة كالعاقبة والعافية ، والظاهر أنّ الغرض النظر إلى ما يحلّ النظر إليه على وجه الحرام أي على وجه الالتذاذ ، كالنظر إلى وجه الأمرد على وجه الالتذاذ ، وهذا هو الذي لا يطلع عليه غير الله سبحانه لابتنائه على الاطلاع على الباطن وأما النظر إلى من يحرم النظر إليه فهو وإن كان في بعض الأوان لا يطلع عليه غير الله سبحانه ، لكن يمكن الاطلاع عليه لغير الله سبحانه في كثير من الأوان. والوجه الأوّل لا يطلع عليه غير الله سبحانه أصلاً ، فهو الأولى بتوصيف الله سبحانه في مقام التعظيم ، بل هو الأظهر مع قطع النظر عما ذكر.
فقد بان الإشكال في التفسير بمسارقة النظر إلى من لا يحل النظر إليه ، وربما حكي التفسير بالرمز بالعين ، وكذا التفسير بقول الإنسان رأيت ما رأى وما رأيت وقد رأى.
في تفسير عدّة من خواص النبيّ صلى الله عليه وآله من حرمة خائنة الأعين
ثم إنه قد عدّ الخاصة والعامة نقلاً من خواص النبيّ صلى الله عليه وآله حرمة خائنة الأعين ، وعن العلّامة في «التحرير» التفسير بالغمز بالعين ، قال : «بل كان عليه أن يصرح بشيء من غير تعريض»(١) .
وعن التفتازاني أنه سمي بذلك لأنه يشبه الخيانة من حيث الخفاء ، وفسّر في «جامع المقاصد» بالإيماء إلى مباح خلاف ما يظهر ويشعر به الحال ، قال : «وإنما قيل له خائنة الأعين لأنه يشبه الخيانة من حيث إنه يخفى ولا يحرم على ذلك غيره إلّا في محظور»(٢) ، وحكي عن «التذكرة» التفسير بأن يظهر خلاف ما يضمر(٣) .
قوله : «وَيا مَنْ لَا تُغَلِّطُهُ الْحاجاتُ ».
يعني أنّ كثرة عرض الحاجات في زمان واحد عليه لا يوجب وقوعه سبحانه في الغلط ، كما هو الحال في المخلوقين.
قوله : «وَيا مَنْ لَا يُبْرِمُهُ إِلْحاحُ الْمُلِحِّينَ ».
يعني أنّ إلحاح الملحّين لا يوجب برمه ، أي ملاله ، كما يرشد إليه أن عدّ في القاموس من معاني البرم ـ بالتحريك ـ : الضجر(٤) .
قوله : «يا مُدْرِكَ كُلِّ فَوْتٍ ».
أي فائت ، والفوت السبق يقال فاته أي سبقه فلم يدركه كذا ذكره في «البحار»(٥) .
__________________
(١) تحرير الأحكام : ٣: ٤١٧.
(٢) جامع المقاصد : ١٢: ٥٦.
(٣) تذكرة الفقها : ٢: ٥٦٦ ، الطبعة القديمة.
(٤) القاموس المحيط : ٤: ١٠٧ ، مادّة «برم».
(٥) بحار الأنوار : ٩٨: ٣٠٣.
والغرض على هذا أنه سبحانه لا يلغب أحد عليه ، وهو نظير قوله سبحانه : ( وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ) (١) .
وفي «المصباح» : وفاته فلان بذراع سبقه بها(٢) .
قوله : «وَيا جامِعَ كُلِّ شَمْلٍ ».
أي جامع كل متفرق قال في «المصباح» : «وجمع الله شملهم أي ماتفرق من أمرهم وفرق شملهم أي ما اجتمع من أمرهم»(٣) ، وفي «البحار» الشمل : الأمر وما اجتمع من الأمر(٤) .
وأنت خبير بأن مُقضتى ما ذكر من عبارة «المصباح» اشتراك الشمل بين الضدين ، كما أنّ مقتضاه كون الشمل في المقام بمعني ما تفرق من الأمر وهو مقتضى ما ذكر في الترجمة الفارسية ، حيث ترجم قوله المشار إليه أعني «وَيا جامِعَ كُلِّ شَمْلٍ » بـ «أي فراهم اورنده هر براكنده» ، بل لا مجال لكون الشمل هنا بمعنى الجمع أو ما اجتمع من الأمر ، اللهم إلّا أن يكون الغرض أنّ تأسيس كل جمع وما اجتمع من الأمر منه سبحانه.
قوله : «وَحُزُونَةَ مَنْ أَخافُ حُزُونَتَهُ ».
قال في «البحار» : الحزونة : الخشونة(٥) .
لكن لم أظفر بذكر هذه اللفظة في اللغة فضلاً عن تفسيرها بالخشونة.
إلّا أنّ الظاهر كونها بمعنى الهم ، كما هو الحال في الحزن ، فالغرض استدعاء
__________________
(١) الواقعة ٥٦: ٦٠.
(٢) المصباح المنير : ٤٨٢ ، مادّة «فوت».
(٣) المصباح المنير : ٣٢٣ ، مادّة «شمل».
(٤) و (٥) بحار الأنوار : ٩٨: ٣٠٣.
كفاية هم من خفيف همّه ، كما هو مفاد قوله :وَتَكْفِيَني هَمَّ مَنْ أَخافُ هَمَّهُ .
قوله : «أَنْقَلب عَلىٰ ما شاء اللهُ ».
قال في «البحار» : أي كائناً على هذا القول وهذه العقيدة وخبر الموصول محذوف أي ما شاء الله كان(١) .
وليس بالوجه ، إذ الظاهر أنّ المجرور بالجار هو الموصول لا الجملة فليس الموصول مبتدأ محذوف الخبر ، فالغرض الانقلاب على المعنى لا اللفظ.
تذييلٌ : في كلام من السيّد الداماد
قد عقد السيّد الداماد في الرواشح كلاماً لكلمات وقع التصحيف والاشتباه فيها من معاصريه وأظهر الحق فيها وشنع على معاصريه ، وعمل أيضاً رسالة فيما ذكر ، ومورد بعض تشنيعاته هو شيخنا البهائي ، وقد عدّ في الرواشح والرسالة من تلك الكلمات قوله : في الزيارة المبحوث عنها «وبايعت وتايعت على قتله» قال : كلتاهما بالمثناة من تحت بعد الألف وقبلها موحدة في الأولى ومثناة من فوق في الثانية كتخصيص بعد التعميم إذ (المبايعة) بالباء الموحدة مفاعلة من البيعة بمعنى المعاقدة والمعاهدة سواء كانت على الخير أم على الشر و (المتايعة) بالتاء المثناة من فوق معناها المجازات والمساعاة والمهافتة والمعاضدة على الشر ولايكون في الخير وكذلك التتايُع التهافت في الشر والتسارع إليه مفاعلة وتفاعلاً من التيعان ، يقال : تاع الشيء يتيع تيعاً وتيعاناً : خرج ، وتاع الشيء : ذاب وسال على وجه الأرض ، وتاع إلى كذا [يتيع]إذا ذهب إليه وأسرع ، وبالجملة بناء المفاعلة والتفاعل منه لا يكون إلاّ في الشر ،[وجماهير القاصرين من أصحاب العصر يصحفونها ويقولون] والمصحِّف المغلاط صحّفها وفطنها (تابعت) بالتاء المثناة والباء
__________________
(١) بحار الأنوار : ٩٨: ٣٠٣.
الموحّدة ، وسقم نسخاً قديمة هي مصححة من مصباح المتهجّد بحَكِ إحدى النقطتين وجماهير القاصرين سائرون مسيره في التصحيف»(١) .
والظاهر أنّ المقصود بالمصحِّف المِغلاط هو شيخنا البهائي بشهادة حكاية مسير السائرين مسيره ، إذ لم يكن لغير شيخنا البهائي استعداد أن يسير غيره مسيره ، لكن قد سمعت أنّ بعضاً من النسخ القديمة كان بالتاء المثناة من فوق والباء الموحدة ، وقد سمعت أنّ بعض النسخ في هذه الأعصار بالمنثاة من فوق والمثناة من تحت ، وهو نادرٌ ، هذا.
ومقتضى كلامه كون عبارة «المصباح» جامعة بين الموحّدة والمثناة بعد الألف مع أنّه ليس في «المصباح» إلّا إحداهما ، نعم ما في زاد المعاد كتحفة الزائر جامع بينهما.
وفي «المجمع» : في الدعاء : «ونعوذ بك أن تتايع بنا أهوائنا دون الهدى الذي جاء من عندك» التتايع التهافت والشرّ واللّجاج ، وهو كالتتابع ، لكن الأوّل لا يكون إلاّ في الشر والثاني يكون في الخير والشر ، والمعنى أنّ تتابع في طلب الشر»(٢) .
ومقتضى كلامه صحة (تابعت) بالباء الموحدة بعد الألف ، وكذا صحّت (تايعت) بالمثناة بعد الألف.
__________________
(١) الرواشح السماويّة : ٢١٦.
(٢) مجمع البحرين : ١: ٣٠٣ ، مادّة «ت ي ع».
[التنبيه] الثالث والعشرون :
في جواز النيابة في زيارة عاشوراء
أنّه هل يجوز النيابة في الزيارة المبحوث عنها أم لا؟
أقول : إنّ الظاهر أخبار زيارة عاشوراء وإن كان هو المباشرة بل هو الحال في جميع العبادات من الواجبات والمندوبات ، وفاقاً للأشاعرة ، بل نقل عليه إجماع الطائفة ، وخلافاً للمعتزلة ، وقد حرّرنا التفصيل في الأصول ، لكن مقتضى الاستقراء في الأخبار الواردة في جواز زيارة النبيّ صلى الله عليه وآله والامام عليه السلام عن القريب ، وكذا جوازها تبرعاً واستدعاءاً ، وكذا جوازها للحي والميّت ، وكذا جواز النيابة في الصوم والحج جواز النيابة في المقام واهداء الثواب إلى المقصود بالنيابة عنه ، والأخبار المذكورة قد استوفاها في «البحار» في باب الزيارة بالنيابة عن الأئمّة عليهم السلام وغيرهم(١) .
ويرشد إلى ذلك الإستقراء أخبار النيابة في الحج ، كما ورد في وجوب استنابة الموسر إذا منعه مرض أو غيره(٢) ، وكذا ما ورد في وجوب الاستنابة لمن استقر في ذمته الحج ولم يحج وإن لم يوص بالحج عمّن وجب عليه الحج ولم يحج حتى مات(٣) .
ويرشد إليه أيضاً ما دلّ من الأخبار على جواز الاستنابة في مطلق النوافل ، بل بعضها يدل على جواز النيابة في الصّلاة الواجبة ، وقد ذكر في الذكرى تلك الأخبار نقلاً.
__________________
(١) بحار الأنوار : ٩٩: ٢٥٥.
(٢) فراجع في ذلك وسائل الشيعة : ١١: ٦٣ ، الباب ٢٤ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.
(٣) فراجع في ذلك وسائل الشيعة : ١١: ٧١ ، الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.
ويرشد إليه أيضاً ما دل على كفاية التبرّع بما فات من الميت ، وكذا ما ورد في وجوب كفاية التبرّع بما فات من الميت من صيام تمكن من قضائه ولم يقضه.
ويرشد إليه أيضاً ما نقل من الإجماع على قبول الزكاة والخمس والكفارات والصدقات المندوبة للنيابة.
ثم أنه لا فرق في المقام بناءً على جواز النيابة بين كون المنوب عنه حيّاً وكونه ميّتاً ولا بين كون النيابة من باب التبرع وكونها من باب استدعاء الوقوع من الحيّ أو الميت حال الحياة ، وأيضاً لا فرق في الجواز بين صورة القدرة على المباشرة وصورة تعذرها ، ولا إشكال في جواز النيابة في المقام في صورة التعذر بناءً على أصالة الاستنابة في تعذّر المباشرة في الواجب كما جرى عليه جماعة من الفقهاء ، إلّا أن القول به بمعزل عن التحقيق ، وقد حرّرنا تفصيل المقال في الأصول.
[التنبيه] الرابع والعشرون :
فيما روي من سوانح يوم عاشوراء
أنّ المروي في «التهذيب» في كتاب الصوم عند الكلام في صوم يوم عاشوراء بسنده عن كثير النوا ، عن أبي جعفر عليه السلام : «أنّه لزقت السفينة يوم عاشوراء على الجُودي فأمر نوح عليه السلام ومن معه من الجنّ والإنس أن يصوموا ذلك اليوم ، وتاب الله فيه على آدم وحواء عليهما السلام ، وفلق الله فيه البحر لبني إسرائيل فأغرق فرعون ومن معه وغلب فيه موسى فرعون ، وولد فيه إبراهيم ، وتاب الله فيه على قوم يونس ، وولد فيه عيسى بن مريم ، ويقوم فيه القائم عليه السلام »(١) .
لكن بعد الإغماض عن سند الخبر المذكور روى في التهذيب في أول باب صيام رجب عن كثير بياع النوا عن أبي جعفر عليه السلام ...: «أن نوحاً عليه السلام ركب السفينة في أوّل يوم من رجب فأمر من معه من الجنّ والإنس أن يصوموا ذلك اليوم ...؟ »(٢) .
وقد ذكر في «الوافي» في كتاب الصوم في باب صوم يوم عاشوراء والإثنين «إنّ ما دل عليه الخبر المذكور من أنّ ولادة الخليل عليه السلام كانت في يوم عاشوراء مُعارَضٌ بما دلّ على أنّها كانت في أوّل يوم من ذي الحجة أو في خمس وعشرين من ذي القعدة»(٣) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٤: ٣٠٠ ، باب وجوه الصيام ، الحديث ١٤.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤: ٣٠٦ ، باب صيام رجب والأيّام منه ، الحديث ١.
(٣) الوافي : ٧: ٧٦ ، باب صيام يوم عاشوراء والإثنين ، في ذيل الحديث ١٠٤٤٣ ـ ١١ ، وما نقله المصنّف عنه بالمعنى فإنّ عبارته هكذا : «ولأنّ يدلّ على أنّ ولادة الخليل عليه السلام كانت فيه مع أنّه قد مضى أنّها كانت في أوّل يوم من ذي الحجّة أو في خمس وعشرين من ذي القعدة».
وفي «الوافي» في الموضع المشار إليه عن الصدوق في المجالس بسنده : عن ميثم التمار : «أنّ هذه الاُمّة سيزعمون بحديث يضعونه أنّ يوم عاشوراء هو اليوم الذي تاب الله فيه على آدم عليه السلام وإنّما تاب الله على آدم في ذي الحجة. ويزعمون أنّه اليوم الذي قبل الله فيه توبة داود عليه السلام وإنّما قبل الله توبته في ذي الحجة. ويزعمون أنه اليوم الذي أخرج الله فيه يُونس من بطن الحوت ، وإنّما أخرجه الله من بطن الحوت في ذي العقدة. ويزعمون أنّه اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح على الجودي ، وإنّما استوت على الجودي يوم الثامن عشر من ذي الحجة. ويزعمون أنه اليوم الذي فلق الله فيه البحر لبني اسرائيل ، وإنّما كان ذلك في الربيع الأوّل »(١) .
__________________
(١) الوافي ٧: ٧٧ ، باب صيام يوم عاشوراء والإثنين ، في ذيل الحديث المتقدّم.
[التنبيه] الخامس والعشرون :
في منام يدلّ على فضيلة زيارة عاشوراء
أنّه حكي أنّه كان رجل صالح فاضل يبيت في الليالي في مقبرة ، وكان له جار نشأ معه من صغر سنه عند المعلّم وغيره إلى أن صار عشّاراً(١) في أوّل كسبه ، وكان كذلك إلى أن مات ودفن في تلك المقبرة قريباً من المحلّ الذي كان يبيت فيه الفاضل المشار إليه ، فرآه بعد موته بأقلّ من شهر في المنام على حُسْنِ الحال ، فقال له : إنّي عالم بمبدئك ومنتهاك ولم يكن عملك مقتضياً إلّا للعذاب والنكال ، فكيف نلت هذا المقام؟
قال : الأمر كما قلت ، كنت مقيماً في أشدّ العذاب من يوم وفاتي إلى الأمس وقد توفّيت فيه زوج حداد ـ وذكر اسم الحداد ـ ودفنت في هذا المكان ـ وأشار لأي مكان بينهما قريب من مائة ذراع ـ وفي ليلة دفنها زارها أبو عبد الله عليه السلام ثلاث مرات ، وفي المرّة الأخيرة أمر بدفع العذاب عن هذه المقبرة فصرت في نعمة وسعة ، فلما انتبه ولم يكن له معرفة بالحداد المذكور ، فطلبه فوجده فقال له : ألك زوجة؟
قال : نعم توفيت بالأمس ودفنتها وذكر مكان الدفن في الموضع الذي أشار إليه المشير المشار إليه.
قال : فهل زارت أبا عبد الله عليه السلام؟
قال : لا.
قال : فهل كانت تذكر مصائبه؟
قال : لا.
__________________
(١) العشّار : هو من يأخذ ضريبة العشر للظالم.
قال : فهل كان لها مجلس يذكر فيه مصائبه؟
قال : لا.
فقال الرجل : وما تريد من السؤال؟
فقصّ عليه الرؤيا وقال : أريد استكشف علاقة بينها وبين الامام عليه السلام.
قال : كانت مواظبة لزيارة عاشوراء.
[التنبيه] السادس والعشرون :
في قصّة وقضيّة(١)
أنّه حكي عن بعض التواريخ نقلاً أنه أخبر الخليفة أن شيخنا الطوسي وأصحابه يسبّون الصحابة وكتابه «المصباح» يشهد بذلك ، فإنه ذكر أن من دعاء يوم عاشورا :
«اللّهُمَّ خُصَّ أنْتَ أَوَّلَ ظالِمٍ بِاللَّعْنِ مِنّي ، وَابْدَأْ بِهِ أَوَّلاً ، ثُمَّ الْعَنِ الثّاني وَالثّالِثَ وَالرّابِعَ. اللّهُمَّ الْعَنْ يَزيدَ خامِساً » ،
فدعي الخليفة بالشيخ والكتاب ، فلمّا حضر الشيخ وقفه على القصّة ، فألهمه الله أن ذكر أنّه ليس المراد من هذه الفقرات ما ظنّه المفسّرون ، بل المراد بالأوّل : قابيل قاتل هابيل وهو أول من سنّ القتل والظلم. وبالثاني : عاقر ناقة صالح. وبالثالث : قاتل يحيي بن زكريا. وبالرابع : عبدالرحمن بن ملجم قاتل عليّ بن أبي طالب ، فلمّا سمع الخليفة ما سمع قبل ورفع شأن الشيخ وانتقم ممّن أفسد.
وقد أعجبني أن أذكر بالمناسبة من باب الإعتبار لأولي الأبصار ما حكاه المحدّث الجزائري في «شرح التهذيب» : «من أنه ورد في العام الخامس والتسعين بعد الألف إلى المدينة المشرّفة فحكى له رجل من ساكنيها من أوثق الإخوان أنه قبل هذا العام أمر رؤساء العامة أن تفتش الكتب والمزارات التي في قبّة أئمة البقيع عليهم السلام فوجدوا فيها مزاراً للمفيد وفيه لعن الأوّل والثاني ، فأرادوا خراب القبة ، فمنعهم بعض الناس واجتمع علمائهم من الشافعية واتفق رأيهم أن يمضوا إلى سطان آل عثمان ويخبروه بما جرى حتى يأمر بخراب القبّة وقتل من في المدينة من الشيعة وإخراجهم عنها ،
__________________
(١) نقل هذه القصّة التستري في قاموس الرجال : ٩: ٢٠٨ في ترجمة الشيخ الطوسي ، كما ذكر القصّة القاضي الشهيد نور الله التستري في مجالس المؤمنين : ١: ٤٨١.
خصوصاً سادات بني حسين. فلمّا وصلوا إلى استنبول أمر السلطان لهم بالضيافة والإحترام ، فقال لوزيره : نحبّ أن نصلّي هذه الجمعة خلف أعلمهم لأنّهم من أهل المدينة ، فعيّنوا يوم الجمعة إماماً منهم ، وصلّى السلطان والناس خلفه ، فلمّا أتى على القراءة ترك قراءة البسملة مع أنه شافعي المذهب ومن مذهبه وجوبها ، فلمّا فرغ من الصلاة سأله السلطان : لم تركت قراءة البسملة؟ فقال : رعاية لمذهب السُّلطان لأنه حنفيّ. فقال له السلطان : الدين خصوصاً العبادة لا يجوز فيه رعاية السلاطين لأنها عبادة الله سبحانه لا للسّلطان ولا تقية هنا الجأتك إلى هذا ؛ لأن الكلّ عندنا محق ، الحنفي والشافعي ، وأيضاً بترك البسملة يبطل صلاتك لاعتقادك وجوبها ، وإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم ، فأمر عليهم بضرب الأعناق ، فالتمس الوزير منه بالعفو عن قتلهم وأن يخرجوا من البلد في تلك الساعة على أخسّ حال وأقبح هيئة.
فركبوا في السفن قادمين إلى المدينة ، فلمّا توسّطوا البحر مات منهم جماعة وقدم أقلهم إلى المدينة ، فما بقوا إلّا أياماً قليلة حتى أتى الله سبحانه على أعمارهم ، فانقطعت مادة الفساد».
وانظر أيّها اللبيب أنّ الله سبحانه كيف يجازي العمل ، وكيف يُدبّر ، وكيف يحدث الخيال ، فتفرّغ وانقطع إليه في جميع الأحوال ، وقد رأيت عجائب من مجازات الأعمال وإحداث الخيال في المحصّلات والمنقولات ، ولنعم ما حكي من يوسف من التعجّب من تدابير الله سبحانه.
[التنبيه] السابع والعشرون :
في حال رواية سند زيارة عاشوراء ودعاء الوداع
في سند رواية كامل الزيارة
في تحرير حال ما تقدم من سند رواية الزيارة المتقدّمة وسند رواية دعاء الوداع.
سند رواية كامل الزيارة
أمّا رواية كامل الزيارة فسندها المتقدم : حكيم بن داود وغيره ، عن محمّد بن موسى الهمْداني ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة وصالح بن عقبة معاً ، عن علقمة بن محمّد الحضرمي ومحمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن مالك الجهني ، عن أبي جعفر عليه السلام.
أما حكيم بن داود : فهو غير مذكور في الرجال ، لكن لا ضير فيه بواسطة مشاركة غيره معه في الرواية ، بناء على أنّ الظاهر كون الغير واحداً أو اثنين ، فيحصل شبيه الاستفاضة بناءً على كون المدار في الاستفاضة على ما فوق الإثنين لو كان الغير واحداً ، ونفس الاستفاضة بناءً على كون المدار على ما فوق الواحد لو كان الغير واحداً أو اثنين ، وكذا الحال بناءً على كون المدار فيها على ما فوق الإثنين لو كان الغير اثنين ، وعلى الأوّل تتأتى الشباهة من جهة أخرى أيضاً ، وإنما قلنا يحصل نظير الاستفاضة إذ المدار في الاستفاضة على تعدّد تمام السند ، والمتعدّد هنا جزء السّند ، وأما كفاية نظير الاستفاضة وهي بواسطة خروج الأمر عن مورد الإجماع على عدم الحجيّة لعدم اعتبار الخبر الضعيف إجماعاً ، كما هو الحال في الإستفاضة فيتأتّى الحجيّة ، بناء على حجيّة مطلق الظن ، وكذا بناءً على حجيّة الظنون الخاصّة
لمجيء التبيّن ، ونظير الأمر في المقام بناءً على حجيّة مطلق الظن ما لو كان الأخبار في الاستقراء في الأخبار ضعيفة ، حيث إنه يتأتى حينئذٍ حجيّة الظن الناشئ من الإستقراء وأن كان كل من الأخبار ضعيفة ، لخروج الظن الناشئ من الإستقراء عن الإجماع على عدم اعتبار الخبر الضعيف لاختصاصه بالخبر الضعيف المنفرد في مورده ولا يرتبط هذا بالظن الناشئ من مجموع الأخبار الضعيفة المتعدّدة ، وأما بناءً على حجيّة الظنون الخاصة فلا يتأتى الحجيّة.
وإن قلت : إنّه يتأتى التبين فيتأتى الحجيّة.
قلت : إنه لابدّ في باب التبيّن من اختلاف المتبين عنه والمتبيّن به كما في الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة ، وليس في المقام إلّا أمر واحد أعني الظنّ بالكلية الناشئ من الأخبار الضعيفة.
إلّا أن يقال : إنه إنّما يتأتى لو كان الإستقراء بحسب الأفراد على مقدار لا يفيد ما دونه الظنّ بالكليّة وأما لو كان نصف أفراد الإستقراء مثلاً كافياً في الظنّ بالكليّة فيتأتى التبين لانجبار الظنّ بالكلّيّة الناشئ من طائفة أخرى من الأخبار.
وإن قلت : إنه حينئذٍ يتحصّل العلم لانضمام الظنّ بالظن ، وهو خلاف المفروض.
قلت : غاية الأمر قوة الظنّ ولا يلزم حصول العلم.
وأما محمّد بن موسى الهمْداني : فقد حكى النجاشي أنّه «ضعفه القميّون بالغلوّ ، وكان ابن الوليد يقول : إنّه كان يضع الحديث والله أعلم»(١) .
وقال في الخلاصة : «يروي عن الضعفاء ، ضعفه القمّيون بالغلو ، وكان ابن الوليد يقول إنه كان يضع الحديث ، والله أعلم»(٢) .
__________________
(١) رجال النجاشي : ٣٣٨ ، ترجمة ٩٠٤.
(٢) خلاصة الأقوال ـ القسم الثاني : ٤٠١ ، ترجمة ١٦١٨.
وقال ابن الغضائري : «إنّه ضعيف يروي عن الضعفا ، ويجوز أن يخرج شاهداً ، تكلّم القمّيون فيه فأكثروا واستثنوا من كتاب نوادر الحكمة ما رواه»(١) .
قوله : «من كتاب نوادر الحكمة».
قد ذكر النجاشي في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري(٢) : «أنّ له كتباً منها كتاب نوادر الحكمة» ، والظاهر أنّ المقصود بالحكمة المضاف إليها النوادر هو الأخبار المتعلقة بالأمور المربوطة بالعقل كأصول الدين وغيرها ، وقد ذكر النجاشي أيضاً : «أنّ نوادر الحكمة يعرفه القميون بـ (دبة شبيب) وشبيب كان فامياً بقم له دبة ذات بيوت يعطى منها ما يطلب منها فشبهوا هذا الكتاب بذلك».
قوله : «بدبة شبيب».
الدّبة بالفتح ظرف الدّهن كما في الطراز نقلاً ، وفي الجمع «الدبة بفتح المهملة وتشديد الموحّدة وعاء يوضع فيه الدهن[ونحوه] و (دبة شبيب) اسم كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى ، وشبيب رجل كان بقم له دبة ذات بيوت يعطي منها ما يطلب [من دهن] منه ، فشبّهوا هذا الكتاب به [بها](٣) .
قوله : «كان فامياً».
قال في «الصحاح» : «الفوْم الحمّص(٤) لغة شامية ، وبائعة فامي [مغير عن
__________________
(١) بناء على نقل العلّامة في الخلاصة المصدر السابق.
(٢) رجال النجاشي : ٣٤٨ ، ترجمة ٩٣٩.
(٣) مجمع البحرين : ٢: ٦ ، مادّة «دبة».
قوله : «الحمص» ـ بكسر الحاء وتشديد الميم المفتوحة ـ كما عن تغلب ، أو المكسورة كما عن المبرد ، وفيما رواه الكليني بسنده : عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه السلام : «أنّ العدس تسمّونه الحمص ، ونحن نسمّيه العدس».
(٤) وروى أيضاً بسنده : عن معاوية بن عمّار ، قال : «قلت لأبي عبدالله عليه السلام : إنّ الناس»
فومي] لأنّهم قد يغيّرون في النسب»(١) .
وفي «المجمع» في ندر : «وكتاب نوادر الحكمة تأليف الشيخ الجليل محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمّي يشتمل على كتب عديدة ، وعن ابن شهرآشوب أن كتاب نوادر الحكمة اثنان وعشرون كتاباً»(٢) .
وقد حكى النجاشي في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى «أنه استثنى محمّد بن الحسن بن الوليد من روايات محمّد بن يحيى ما رواه محمّد بن موسى الهمْداني ومحمّد بن عيسى بن عبيد وغيرهما من جماعة وكذا أصنافاً من رواياته.
وحكى عن أبي العباس بن نوح أنه قال : وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلّه وتبعه أبو جعفر بن بابويه رحمه الله على ذلك إلّا في محمّد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رابه فيه لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة»(٣) .
وقد حكى العلّامة في «الخلاصة» في الفائدة الرابعة(٤) من الفوائد المرسومة في آخرها عن ابن الوليد وابن نوح ما سمعت حكايته عن النجاشي.
__________________
«يروون أنّ العدس بارك عليه سبعون نبيّاً. فقال : هو الذي يسمّونه عندكم الحمّص ونحن نسمّيه العدس» ، ومقتضاه تطرّق المعنى الجديد في باب العدس يكون المقصود به في لسان النبيّ صلى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام الحمّص ، وبملاحظة ما ذكر من الخبرين حمل في الوسائل ما روي عن أبي عبدالله عليه السلام : قيل له : إنّ هؤلاء يقولون إنّ العدس قدّس عليه ثمانون نبيّاً. فقال : كذبوا، لا والله ولا عشرون نبيّاً» على العدس بالمعنى اللغوي ، وحمل ما دلّ على أنّ أكل العدس يرقّ القلب ، ويسرع الدمعة على الحمص. منه رحمه الله.
(١) صحاح الجوهري : ٥: ٢٠٠٥ ، مادّة «فوم».
(٢) مجمع البحرين : ٤: ٢٨٨ ، مادّة «ندر».
(٣) رجال النجاشي : ٣٤٨ ، ترجمة ٩٣٩.
(٤) خلاصة الأقوال : ٤٣٠ ، الفائدة الرابعة.
وقد حكى العلّامة في الخلاصة في ترجمة خالد بن سدير(١) عن الشيخ الطوسي أنه قال : له كتاب ، ذكر أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه عن محمّد بن الحسن بن الوليد أنه قال : لا أرويه ؛ لأنه موضوع وضعه [محمّد بن موسى الهمْداني].
ومقصوده بما حكاه عن الشيخ ماقاله في «الفهرست».
وقال في «الفهرست» في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى : «وقال محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه : إلّا ما كان فيه تخليط ، وهو الذي يكون طريقه محمّد بن موسى الهمْداني ...»(٢) إلى آخر ما قاله.
وضعفه في المشتركات(٣) .
وفي «الفقيه» في آخر باب صوم يوم التطوّع : «وأما خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه ، كان شيخنا محمّد بن الحسن رضي الله عنه كان لا يصحّحه ، ويقول إنه من طريق محمّد بن موسى الهمْداني ، وكان غير ثقة ، وكل ما لم يصحّحه ذلك الشيخ رحمه الله ولم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح»(٤) ، انتهى.
أقول : إنّ تضعيف القميّين غير موجب لضعف الخبر ، ولا سيّما بالغلو ؛ لأنّه لا ينافي اعتبار الخبر خصوصاً مع ما ذكره النجاشي من أنّ محمّد بن موسي الهمْداني له كتاب في الردّ علي الغلاة ، لكن نسبة وضع الحديث يوجب ضعفه بنفسه ، بل عدم ثبوت اعتباره يكفي في عدم اعتبار خبره.
فما قيل : يمكن إرجاع هذه الكلمات إلى تضعيف القمّيين ومحمّد بن الحسن بن
__________________
(١) خلاصة الأقوال ـ القسم الثاني : ٣٤٤ ، ترجمة ١٣٦٣ ـ ٢.
(٢) فهرست الشيخ : ٤٠٠ ، ترجمة ٦٢٣.
(٣) الظاهر أنّ مراده بالمشتركات : هداية المحدّثين للكاظمي.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ٢: ٩٠/١٨١٧.
الوليد شيخ القمّيين ووجههم ، والنجاشي ترديد له في ضعفه ، حيث نسب التضعيف والرمي بالغلو إلى القميين ، ثم نسب إلى ابن الوليد ما نسب ، ثم قال : والله اعلم ، وقريب منه كلام ابن الغضائري وقد صرّح بأنه يجوز أن يخرج روايته شاهداً ، وقد ذكر أوّل المجلسيين في حاشية الفقيه : أنه كتب الردّ على الغلاة ، والحاصل : أنه لم يتحقق ضعفه.
يضعف : بأنه لا حاجة إلى تحقّ الضعف ، بل يكفي عدم ثبوت الإعتبار ، مع أن نسبة وضع الحديث من ابن الوليد لا يكون مستنداً إلى رمي القميين بالغلو حتى لا يكون معتبراً.
وأما محمّد بن خالد الطيالسي : فقد ذكر الشيخ في الفهرست «له كتاباً»(١) .
وهذا ومثله يوجب حسن الحديث على ما يقتضيه صريح بعض الكلمات.
لكن الحق في اعتبار الحديث الحسن على أنّ المدار على مايوجب الظن بالصدور ، بل على هذا المنوال الحال في نحو فاضل.
في أن الشيخ في الرجال كثيراً ما ذكر الرجل تارة في باب من يروي وأخرى في باب من لم يرو.
وقد ذكره الشيخ في الرجال تارة في أصحاب الكاظم عليه السلام(٢) ، وأخرى في باب من لم يرو(٣) .
__________________
(١) فهرست الشيخ : ٤٢١ ، ترجمة ٦٤٩.
(٢) رجال الشيخ : ٣٤٣ ، ترجمة ٥١٢٥ ـ ٢٦ في أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام.
(٣) رجال الشيخ : ٤٤١ ، ترجمة ٦٣٠٤ ـ ٥٤ ، باب من لم يرو عن واحد من الأئمّة عليهم السلام ، حيث قال في ترجمته : «محمّد بن خالد الطيالسي ، يكنّي أبا عبدالله. روى عنه حميد اُصولاً كثيرة ، ومات سنة تسع وخمسين ومأتين ، وله سبع وتسعون سنة».
ونظيره(١) قد وقع من الشيخ كثيراً ، ويرشد إليه ما ذكره التفرشي في ترجمة القاسم بن محمّد الجوهري من أنّ الشيخ في الرجال قد ذكر كثيراً من الرجال تارة في باب من يروي وأخرى في باب من لم يرو وعد جماعة(٢) ، وذكر تلك المقالة أيضاً في ترجمة معاوية بن حكيم(٣) ، والحسين بن إشكيب(٤) ، وريان بن الصلت(٥) ، بل ذكر في ترجمة عبد الحميد بن سعد : إن ذكر المتحدين بالاختلاف كثير في كلام الشيخ في الرجال ، مع جزمنا بالاتحاد(٦) ، وذكر في ترجمة إبراهيم بن عبدالحميد : إن تعدّد العنوان في كلام الشيخ في الرجال كثير مع عدم التعدد ، كما يظهر من أدنى تتبع(٧) ، وأيضاً قال في باب إبراهيم بن إسحاق(٨) .
وقد يقال : إنّ الشيخ كثيراً ما يذكر في باب من لم يرو رجالاً من أصحاب الأئمّة يعلم من مراجعة الكتاب.
__________________
(١) قوله : «ونظيره» قد وقع من الشيخ كثيراً ، قد علّق السيّد السند النجفي في طيّ الفوائد المرسومة في آخر رجاله ، فائدة لما صنعه الشيخ ، وجعله من الإشكال المشهور ، واحتمل في الجواب وجهين ، وحكى ظهور وجهين آخرين من كلام بعض ، وحكم بضعف الكلّ. منه رحمه الله.
(٢) نقد الرجال : ٤: ٤٥ ، ترجمة ٤١٦٩ ـ ٣٦.
(٣) نقد الرجال : ٤: ٣٨٦ ، ترجمة ٥٣٢٤ ـ ٤.
(٤) نقد الرجال : ٢: ٧٩ ، ترجمة ١٤١٨ ـ ٢٢.
وقوله : «إشكيب» ـ بالهمزة المكسورة والشين المعجمة الساكنة والياء المثنّاة التحتانيّة والباء الموحدة ـ ، قوله : «ريّان» ـ بالراء المفتوحة والياء المثنّاة التحتانيّة المشدّدة والنون ـ. منه رحمه الله.
(٥) نقد الرجال : ٢: ٢٤٩ ، ترجمة ٢٠٠٨ ـ ٢.
(٦) نقد الرجال : ٣: ٣٥ ، ترجمة ٢٨١٠ ـ ٨.
(٧) نقد الرجال : ١: ٧١ ، ترجمة ٩٧ ـ ٦٩.
(٨) نقد الرجال : ١: ٥٤، ترجمة ٤٦ ـ ١٨.
وذكر الشيخ في باب من لم يرو أنه روى عنه علي بن الحسن بن فضال وسعد بن عبد الله ، وكذا روى عنه حميد أصولاً كثيرة(١) .
وقد ذكر العلّامة في الخلاصة في ترجمة صائد النهدي : أنه لم يحضره حال محمّد بن خالد الطيالسي(٢) .
وأما سيف بن عَمِيرَة : بفتح العين المهملة ، فقد قال النجاشي : كوفي ثقة(٣) ، على ما في نسخة معتبرة وهي على ظهرها وآخر الجزء الأوّل خطّ صاحب المعالم وعلى ظهرها خَاتَمَهُ أيضاً ، وذكر بخطّه في آخر الجزء الأوّل : أن النسخة المعتبرة المنقول عنها كأنها بخط ابن إدريس ، وكان عليها خطوط جماعة من العلماء منهم السيّد عبدالكريم بن طاوس وكان كتابة أصل النسخة على ما ذكره الكاتب في آخر الكتاب من باب الخدمة لصاحب المعالم ، وفي آخر الكتاب أن عمره حينئذٍ كان اثنان وعشرون ، وعلى ذلك حال العبارة في نسخة أخرى معتبرة عندي.
__________________
(١) رجال الشيخ : ٤٣٨ ، ترجمة ٦٢٦١ ـ ١١.
والملاحظ أنّ الشيخ في باب مَن لم يرو عن واحد من الأئمّة عليهم السلام ذكر محمّد بن خالد الطيالسي مرّتين :
أولاهما : هذا الموضع برقم ١١ ، فقال : روى عنه عليّ بن الحسن بن فضّال وسعد بن عبدالله.
وثانيهما : برقم ٥٤ ، وقد تقدّم ذكرها في الحاشية المتقدّمة ، حيث قال : «يكنّى أبا عبدالله. روى عنه حميد اُصولاً كثيرة ، ومات سنة تسع وخمسين ومائتين ، وله سبع وتسعون سنة».
كما ذكره في أصحاب الكاظم عليه السلام مقتصراً على ذكر اسمه ، فقال : «محمّد بن خالد الطيالسي».
(٢) خلاصة الأقوال ـ القسم الثاني : ٣٦٠ ، ترجمة ١٤٢١ ـ ١.
(٣) رجال النجاشي : ١٨٩ ، ترجمة ٥٠٤.
وحكى ابن داود(١) ، وكذا جماعة من أهل الرجال توثيقه عن النجاشي.
لكن أورد الاسترآبادي على ابن داود بخلو كلام النجاشي عن التوثيق(٢) .
وقد وثقه الشيخ في الفهرست(٣) ، والعلّامة في الخلاصة(٤) .
وقد حكى الاسترآبادي عن الشهيد [الثاني] في شرح الإرشاد أنّه قال في طيّ قوله : «ولا يجوز نكاح الأمة إلّا بإذن المولى الخ» وربّما ضعّف بعضهم سيفاً ، والصحيح [الظاهر] أنّه ثقة(٥) .
وعن المنتقى أنه صحّح رواية سيف بن عميرة(٦) .
وعن ابن شهر آشوب : أنّه واقفي(٧) .
لكن ذكر أوّلُ المجلسيين في شرح مشيخة الفقيه : أن الحكم بوقفه مشكل ؛ لأن علماء الرجال ذكروه بالتوثيق ، ولم يذكروا وقفه ، ولو كان لما خفي عليهم.
وقال العلّامة البهبهاني في التعليقات نقلاً : «قال جدّي : لم نر من أصحاب الرجال وغيرهم ما يدل على وقفه وكأنه وقع عنه سهواً» ، انتهى.
ويروي عنه ابن أبي عمير وفضالة والحسن بن محبوب وغيرهم وهو كثير الرواية
__________________
(١) رجال ابن داود ـ القسم الأوّل : ١٠٨ ، ترجمة ٧٥١.
(٢) منهج المقال.
(٣) فهرست الشيخ : ٢٢٤ ، ترجمة ٣٣٣.
(٤) خلاصة الأقوال ـ القسم الأوّل : ٦٠ ، ترجمة ٤٦٨ ـ ١.
(٥) منتهى المقال : ٣: ٤٣٤ ، ترجمة ١٤١٣.
(٦) كما في كثير من الموارد في منتقى الجمان ، منها : ١: ١١٣ ، حيث صحّح سنداً فيه سيف بن عميرة.
(٧) معالم العلماء : ٩١ ، ترجمة ٣٧٧ ، حيث قال : «سيف بن عميرة ثقة ، من أصحاب الكاظم عليه السلام ، واقفي. له كتاب».
وسديدها ورواياته مفتى بها ، وليس هذا في نسخة موجودة عندي.
وأما صالح بن عقبة : فهو مشترك بين صالح بن عقبة بن خالد الأسدي وصالح ابن عقبة بن قيس بن سمعان بن أبي ربيحة(١) .
أمّا الأوّل(٢) : فقد ذكره النجاشي والشيخ في الفهرست والرّجال والعلّامة في الخلاصة(٣) ، لكن لم يأت أحد من هولاء بتوثيق ولا مدح له ، بل حكى في الخلاصة عن ابن الغضائري أنه كذّاب غال(٤) ، لكن قال أوّلُ المجلسيين في شرح مشيخة
__________________
(١) قوله : «ربيحة» بضمّ الراء والباء المفردة والياء المثنّاة من تحت والحاء المهملة ، كما في الإيضاح. منه رحمه الله.
(٢) وهو صالح بن عقبة بن خالد.
(٣) فقد ذكره النجاشي في رجاله : ٢٠٠ ، ترجمة ٥٣٤ ، والشيخ في الفهرست : ٢٤٥ ، ترجمة ٣٦٢ ، وفي الرجال ذكر في أصحاب الباقر عليه السلام : ١٣٨ ، ترجمة ١٤٥٩ ـ ٤ مقتصراً على اسمه وأسم أبيه (صالح بن عقبة) ، وفي أصحاب الكاظم عليه السلام : ٣٣٨ ، ترجمة ٥٠٣٧ ـ ٢، فقال : «صالح بن عقبة من أصحاب أبي عبدالله عليه السلام».
والظاهر أنّ المراد بمن هو من أصحاب أبي عبدالله عليه السلام هو صالح بن عقبة بن قيس ، وما ذكره في أصحاب الإمام الباقر عليه السلام مطلقاً هو صالح بن عقبة بن خالد ، فيكون صالح بن عقبة بن خالد من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام فقط ، وصالح بن عقبة بن قيس من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام.
وأمّا خلاصة العلّامة فلم نعثر فيها على ذكر لصالح بن عقبة بن خالد. نعم ، ذكر أخاه عليّ بن عقبة بن خالد ، وأباه عقبة بن خالد ، وذكر أيضاً صالح بن عقبة بن قيس ، هذا على حسب النسخة التي عندي.
وأمّا خلاصة العلّامة فلم نعثر فيها على ذكر لصالح بن عقبة بن خالد. نعم ، ذكر أخاه عليّ بن عقبة بن خالد ، وأباه عقبة بن خالد ، وذكر أيضاً صالح بن عقبة بن قيس ، هذا على حسب النسخة التي عندي.
(٤) بعد التتبّع في الخلاصة وفي كتاب ابن الغضائري لم نعثر على ذكر لصالح بن عقبة بن خالد ، وإنّما المذكور في الخلاصة في شأن صالح بن عقبة بن قيس ، وهو المعبّر عنه بالكذّاب الغال ، وكذلك في رجال ابن الغضائري ، فراجع الخلاصة ـ القسم الثاني في ترجمة صالح بن عقبة بن قيس.
الفقيه : «أنّ الغلو الذي نسبه ابن الغضائري إليه للأخبار التي تدلّ على جلالة قدر الأئمّة عليهم السلام كما رأيناها وليس فيها غلو ، لكن لا ضير في الرواية عن علقمة لشركة سيف بن عميرة في الرواية عنه».
لكن الظاهر أنّ الراوي عن علقمة هو سبط قيس ، إذ الراوي عن مالك هو سبط قيس بشهادة رواية محمّد بن إسماعيل المقصود به محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، كما يظهر مما تقدم لأنه يروي عن سبط قيس ، والظاهر اتحاد صالحين. نعم محمّد بن إسماعيل بن بزيع يروي عن سبط خالد أيضاً ، لكن بتوسّط محمّد بن أيوب ، ومع ذلك في ترجمة عقبة بن قيس أنّه والد صالح بن عقبة ومقتضاه أنّ صالح بن عقبة كان مشهوراً معروفاً ، فالمعروف سبط قيس فيحمل صالح في المقام على سبط قيس ، لكفاية الشهرة في التعيين في باب المشترك في الأسانيد وغيرها ، وعليه يدور رحى المحاورات العرفيه ، وإن أنكر المحقّق القمّي الترجيح بالشهرة في باب المشترك ، لكنه ليس بالوجه ، كما حرّرناه في الأصول.
وأما علقمة بن محمّد الحضرمي : فقد قال الشيخ في الرجال في باب أصحاب الصادق عليه السلام : علقمة بن محمّد الحضرمي أسند عنه(١) ، ولا دلالة فيه على المدح
__________________
(١) رجال الشيخ ـ أصحاب الإمام الصادق عليه السلام : ٢٦٢ ، ترجمة ٣٧٣٢ ، ـ ٦٤١ ، وفي رجال الشيخ : الكوفي ، ثمّ إنّ الشيخ ذكر في أصحاب الإمام الباقر عليه السلام : ١٤٠ ، ترجمة ١٥٠٣ ـ ٣٩ : «علقمة بن محمّد الحضرمي ، أخو أبي بكر الحضرمي».
وذكر أيضاً في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام : ٢٦٧ ، ترجمة ٣٨٣٧ ـ ٧٤٦ : «علقمة بن أبي الحضرمي» ، الظاهر اتّحاد من ذكر في أصحاب الإمام الباقر عليه السلام باسم علقمة بن محمّد الحضرمي مع من ذكر في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام باسم علقمة بن محمّد الحضرمي الكوفي ، وهو أخ لعبدالله بن محمّد الحضرمي المكنّي بأبي بكر الحضرمي ، كما أنّ أبا بكر كنية للأب ، وهو محمّد بن شريح الحضرمي المذكور في أصحاب الإمام الباقر عليه السلام ، حيث قال عنه الشيخ : «محمّد بن شريح الحضرمي ، يكنّى أبا بكر» ترجمة ١٥٧٧ ـ ٨ ، وأمّا»
ولا التوثيق إلاّ بناء على دلالة «أسند عنه» على المدح أو التوثيق ، والأظهر عدم دلالته على شيءٍ منهما ، وقد حرّرنا تفصيل الكلام فيه في بعض الفوائد الرجالية.
وقال الكشّي في ترجمة عبد الله بن محمّد أبي بكر الحضرمي أخي علقمة : حدّثني علي بن محمّد بن قتيبة القتيبي ، قال : حدّثنا الفضل بن شاذان ، قال : حدّثنا أبي ، عن محمّد بن جمهور ، عن بكّار(١) بن أبي بكر الحضرمي ، قال : «دخل أبو بكر وعلقمة على زيد بن عليّ عليه السلام ، وكان علقمة أكبر من أبي ، فجلس أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره ، وكان بلغهما أنّه قال : ليس الإمام [منّا] من أرخى عليه ستره إنّما الإمام من شهر سيفه.
فقال له أبو بكر وكان أجرأهما : يا أبا الحسين ، أخبرني عن عليّ بن أبي طالب أكان إماماً وهو مرخ عليه ستره أو لم يكن إماماً حتى خرج وشهر سيفه؟
قال : وكان زيد يبصر الكلام ، قال : فسكت فلم يجبه ، فرد عليه الكلام ثلاث مرّات كلّ ذلك لم يجبه بشيء.
فقال له أبو بكر : إن كان عليّ بن أبي طالب عليه السلام إماماً فقد يجوز أن يكون بعده إماماً مرخ عليه ستره وإن كان عليّ بن أبي طالب عليه السلام لم يكن إماماً وهو مرخ عليه ستره فأنت ما جاء بك هاهنا؟
قال فطلب(٢) إلى علقمة أن يكفّ عنه ، فكفّ عنه(٣) .
وربّما يقال : إنّ مقتضاه تصلّب أبي بكر في الدّين ، والظاهر أن علقمة كان على
__________________
«مَن ذكره في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام باسم علقمة بن أبي الحضرمي ، فيحتمل أن يكون هو علقمة بن محمّد المذكور.
(١) قوله : «بكّار» بفتح الباء الموحدة وتشديد الكاف. منه رحمه الله.
(٢) الظاهر أنّ الذي قام بالطلب هو زيد ، طلب من علقمة أن يطلب من أخيه الكفّ.
(٣) اختيار معرفة الرجال : ٤٧٨/٧٨٨.
حاله فيثبت به المدح لعلقمة.
وأنت خبير بأنّ من ثبوت حالة الشخص لا يظهر ثبوتها لأخيه ، وربما يظهر القول بذلك المقال ممن قال :
دَعِ الخمرَ يشربْها الغواةُ(١) فإنّني |
رأيتُ أخاها مُغنياً بمكانِها |
|
فإنْ لا يكنْها أو تكنْهُ فإنّهُ |
أخوها غذتْهُ أمُّهُ بلبانِها |
وأمّا محمّد بن إسماعيل : فالمقصود به محمّد بن إسماعيل بن بَزِيع ، كما يظهر مما تقدم وقد سمعت القول به عن قريب أيضاً.
قال النجاشي : «محمّد بن إسماعيل بن بزيع كما يظهر مما تقدم أبو جعفر ، مولى المنصور أبي جعفر ، ووِلْدُ بزيعٍ بَيْتٌ منهم حمزة بن بزيع ، كان من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم كثير العمل له كتب ...»(٢) ، وعن بعض النسخ (الواو) قبل (كان).
وقد اختلف في قوله : (كان من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم) ، فقد جرى ابن داود على رجوع الضمير في (كان) إلى محمّد بن إسماعيل(٣) ، فيعود التوثيق إليه ، وعليه جرى الاسترآبادي(٤) ، وكذا شيخنا البهائي في مشرقه(٥) حاكياً عن حواشيه على الخلاصة ، ومقتضى ما صنعه العلّامة ، حيث ذكر (كان الخ) ، في شأن
__________________
(١) قوله : «الغواة» جمع غاوٍ ، وهو الضالّ. قوله : «أخاه» أي النبيذ الذي يُعمل من الزبيب. قوله : «أمه» أي شجرة العنب. قوله : «بلبانها» ـ بكسر اللام ـ يقال : هذا أخوه بلبان اُمّه ، ولا يقال بلبن اُمّه ، وإنّما اللبن الذي يشرب. منه رحمه الله.
(٢) رجال النجاشي : ٣٣٠ ، ترجمة ٨٩٣.
(٣) رجال ابن داود : ١٦٥ ، ترجمة ١٣١٤.
(٤) راجع في ذلك منهج المقال.
(٥) مشرق الشمسين وإكسير السعادتين أو مجمع النورين ومطلع النيرين : ٢٧٧.
حمزة(١) هو رجوع الضمير(٢) إلى حمزة فيعود التوثيق إليه.
وقد عدّ في المنتقى القول به(٣) مما وقع للمتأخّرين في باب التزكية من جهة قلة التأمّل والمراجعة(٤) ، وظاهر المحقّق القمّي في القوانين في بحث تعارض الجرح والتعديل(٥) ، بل جماعة من المحققين : على كون الرجوع إلى حمزة من باب التوهم ، وظاهر التفرشي التوقف(٦) ، ويظهر تحقيق الحال بالرجوع إلى الرسالة المعمولة في ثقة ، وقد وثّقه الشيخ في الرجال(٧) ، وحكى الكشي عن حمدويه أنّه سأل علي بن الحسن عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، فقال : ثقة ثقة عين(٨) ،
__________________
(١) خلاصة الأقوال ـ القسم الأوّل : ١٢١ ، ترجمة ٣٠٨ ـ ٥ ، حيث قال : «حمزة بن بزيع من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم ، كثير العلم».
(٢) في ترجمة محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، حيث ذكر نصّ العبارة المذكورة في النجاشي.
(٣) يعني رجوع الضمير في «كان» إلى حمزة بن بزيع.
(٤) منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان : ١: ١٨.
(٥) قوانين الاُصول : ٤٧٦.
(٦) نقد الرجال : ٢: ١٦٢ ، ترجمة ١٦٩٣ ـ ٢ ، ذكر ذلك في ترجمة حمزة بن بزيع ، ولكن ما استظهره المصنّف لعلّ الظاهر خلافه ، حيث إنّه ذكر في الترجمة المذكورة : «... من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم ، كثير العمل» ، الخلاصة : وكأنّه أخذ هذا التوثيق من كلام النجاشي عند ذكر محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، حيث قال : وذكر عبارة النجاشي ، ثمّ قال التفريشي : «وفي أخذ التوثيق له من هذه العبارة نظر» ، وذكر ابن داود هذه العبارة في شأن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، ولعلّه الصواب».
(٧) رجال الشيخ : ٣٦٤ في أصحاب الإمام الرضا عليه السلام ، ترجمة ٥٣٩٣ ـ ٦ ، حيث قال : «محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، ثقة ، صحيح ، كوفي ، مولى المنصور».
(٨) الظاهر أنّ هذه النسبة للكشّي اعتماداً على نسخة عند المصنّف ، وأمّا النسخة التي بين أيدينا فلا توجد فيها هذه النسبة.
نعم ، ذكر العلّامة في الخلاصة في ترجمة محمّد بن إسماعيل بن بزيع هذا الكلام»
والظاهر أنّ المقصود بعلي بن الحسن هو علي بن الحسن بن فضال ، لأنّه قد عدّ من كتبه الرجال ، واطّلاعه على أحوال الرجال يقتضي مناسبته للسؤال عن الحال ، مع أنّه أشهر من غيره ، والشهرة من المرجحات في باب المشترك كما سمعت.
وأما مالك الجهني : فهو مالك بن أعين ، وقد حكى الكشي عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن الحسن بن علي بن يقطين : أنّه ليس من هذا الأمر في شيء(١) .
وحكى في الخلاصة عن العقيقي عن أبيه عن أحمد بن الحسن عن أشياخه أنه كان مخالفاً(٢) .
وعدّه الشيخ في الرجال من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام ، وذكر أنّه مات في حياة الصادق عليه السلام(٣) .
وقال ابن داود : قر(٤) .
__________________
«عن عليّ بن الحسن.
(١) اختيار معرفة الرجال : باب في بني أعين : مالك وقعنب ، رقم ٣١٨ ، وهذا نصّ عبارته : «حدّثني حمدويه ، قال : حدّثني محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، قال : كان لهم غير زرارة إخوته إخوان ليسا في شيء من هذا الأمر : مالك وقعنب».
نعم ، قال العلّامة في الخلاصة في ترجمة مالك بن أعين : «روى الكشّي ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين : أنّ مالك بن أعين ليس من هذا الأمر في شيء.
(٢) خلاصة الأقوال ـ القسم الثاني : ٤١١ ، ترجمة ١٦٦٥ ـ ٧.
(٣) رجال الشيخ ، ذكره في أصحاب الإمام الباقر عليه السلام : ١٤٥ ، ترجمة ١٥٨٩ ـ ١١ ، وقال عنه : «مالك بن أعين الجهني».
وذكره في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام : ٣٠٢ ، ترجمة ٤٤٣٣ ـ ٤٥٨ ، وقال عنه : «مالك بن أعين الجهني الكوفي ، مات في حياة أبي عبدالله عليه السلام».
(٤) رجال ابن داود : ١٥٧ ، ترجمة ١٢٥٣ ، وكلمة «قر» رمز لكونه من أصحاب»
وقال الاسترآبادي : ليس المأخذ معلوماً(١) .
وفي الكافي في باب المصافحة بالإسناد ، عن مالك الجهني ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : «يا مالك ، أنتم شيعتنا إنّك تفرط في أمرنا إنّه لا يُقدَر على صفة الله فكما لا يقدر على صفة الله كذلك لا يقدر على صفتنا ، وكما لا يُقدَر على صفتنا كذلك لا يُقدَر على صفة المؤمن. إن المؤمن ليلقى المؤمن فيصافحه فلا يزال الله ينظر إليهما والذنوب تتحاتّ من وجوههما كما تتحاتّ الورق عن الشّجر حتّى يفترقا فكيف يقدر على صفة من هو كذلك »(٢) .
ومقتضى قوله عليه السلام : «إنّك تفرط في أمرنا » هو شدّة إخلاص مالك بالنسبة إلى الأئمّة.
إلّا أن يقال : إنّ الإفراط لا يخرج عن النقص ، كيف وقد قيل : كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضدّه ، بل الإفراط معدود من النقص كالتفريط.
وعلى أيّ حال في الكافي هنا رواية أخرى عن مالك بن أعين الجهني ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : «إنّ المؤمنَيْنِ إذا التقيا فتصافحا أدخل الله عزّ وجلّ يده بين أيديهما فأقبل بوجهه على أشدّهما حبّاً لصاحبه ، فإذا أقبل الله عزّ وجلّ عليهما تحاتّ عنهما الذنوب كما تحاتّ الورق عن الشجر »(٣) .
وهذه الرواية خالية عما يدل على المدح والذمّ والمقصود بالذمّ حديث الإفراط.
وقيل : قد روى عنه جمع من الثقات كما يظهر من التتّبع في الأخبار ، وظاهرهم الإعتماد عليه.
__________________
«الإمام الباقر عليه السلام ، كما نبّه هو على ذلك في أوّل الكتاب.
(١) منهج المقال.
(٢) اُصول الكافي : ٢: ١٨٠/٦.
(٣) اُصول الكافي : ٢: ١٧٩/٣.
في سند رواية «المصباح»
وأما رواية «المصباح» فسندها كما تقدّم محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وقد يظهر فيما مرّ حال محمّد بن إسماعيل بن بزيع وصالح بن عقبة.
وأما أبو صالح فهو عقبة بن قيس بشهادة رواية محمّد بن بزيع لأنه يروي عن سبط قيس كما هو مقتضى صريح النجاشي والشيخ(١) ، مضافاً إلى ما سمعت من أنّ المذكور في ترجمة عقبة بن قيس أنه والد صالح بن عقبة(٢) ، ومقتضاه كون صالح بن عقبة بن قيس معروفاً فيحمل صالح على كونه سبط قيس وكون والده عقبة بن قيس ، وكيف كان فعقبة بن قيس مجهول الحال ، وقد عدّه الشيخ في الرجال من أصحاب الباقر عليه السلام وصرّح بكونه مجهول الحال نقلاً(٣) .
__________________
(١) في ترجمة صالح بن عقبة ، فأمّا النجاشي فقد قال في ترجمة صالح بن عقبة بن قيس : ٢٠٠ ، ترجمة ٥٣٢ : «له كتاب يرويه عنه جماعة ، منهم : محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، أخبرنا الحسين بن عبيدالله ، عن ابن حمزة ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن ابن أبي الخطّاب ، قال : حدّثنا محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بكتابه».
وأمّا الشيخ في الفهرست في ترجمة صالح بن عقبة : ٢٤٥ ، ترجمة ٣٦٢ ، قال : «له كتاب ، أخبرنا ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة».
(٢) ذكر ذلك الشيخ في رجاله في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ترجمة ٣٧١٥ ـ ٦٢٤ ، حيث قال : «عقبة بن قيس والد صالح بن عقبة ، كوفي».
(٣) ذكر ذلك في أصحاب الإمام الباقر عليه السلام : ١٤٢ ، ترجمة ١٥٣٩ ـ ٧٤ ، حيث ذكر قبل عقبة جماعة ووصفهم بالمجهوليّة ، ثمّ ذكر عقبة وقال مثله ، وهذا نصّ عبارته : «عبدالله بن عمرو ، وعبدالرحمن بن زرعة ، وعمرو بن هلال ، كلّهم مجهولون ، عقبة بن قيس مثله».
إلّا أنّ الملاحظ أنّ الشيخ في الرجال ذكر عقبة بن قيس في أصحاب الإمام»
في سند رواية دعاء الوداع
وأمّا ما رواه في «المصباح» ومزار محمّد بن المشهدي ممّا اشتمل على دعاء الوداع ، فسنده كما تقدم محمّد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن صفوان بن مهران الجمال ، عن الصادق عليه السلام ، وقد ظهر بما مرّ حال محمّد بن خالد وكذا حال سيف بن عميرة.
وأمّا صفوان بن مهران الجمال فقد وثقه النجاشي(١) ، وكذا العلّامة في الخلاصة(٢) ، وعن إرشاد المفيد(٣) : أنّه من شيوخ أصحاب أبي عبد الله عليه السلام وخاصته وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين(٤) ، وصفوان المشار إليه كان جمالاً.
__________________
«الصادق عليه السلام : ٢٦١ ، ترجمة ٣٧١٥ ـ ٦٢٤ ، ووصفه بأنّه والد صالح ، وأنّه كوفي ولم يصفه بالمجهوليّه هنا ، وهذا نصّ عبارته : «عقبة بن قيس ، والد صالح بن عقبة ، كوفي».
ويمكن أن تكون المجهوليّه في عقبة بن قيس بلحاظ أصحاب الباقر عليه السلام ، فهو مجهول كونه من أصحاب الباقر عليه السلام ، ومعلوم كونه من أصحاب الصادق عليه السلام ، ولذلك لم يصفه بالمجهوليّة لما تعرّض له من أصحاب الصادق عليه السلام ، وهذا الوجه غير بعيد باعتبار أنّ كتاب الرجال للشيخ هو بمثابة كتاب طبقات بلحاظ أصحاب الأئمّة عليهم السلام ، فمن يصفه بالمجهوليّة في أصحاب إمام ، ثمّ يذكره في أصحاب إمام آخر ولا يصفه بذلك ، فمعنى ذلك أنّه مجهول بلحاظ تلك الطبقة ، وغير مجهول بلحاظ الطبقة الاُخرى.
(١) رجال النجاشي : ١٩٨ ، ترجمة ٥٢٥.
(٢) خلاصة الأقوال : ١٧١ ، ترجمة ٥٠١ ـ ٢.
(٣) الإرشاد : ٢: ٢١٦ ، فصل في النصّ على الإمام الكاظم عليه السلام.
(٤) من أحفاد صفوان بن مهران ، محمّد بن أحمد بن قضاعة بن صفوان ، المشهور بأبي عبدالله الصفواني ، وقد ذكر النجاشي في ترجمته أنّه كانت له منزلة عظيمة عند السلطان ، وناظر قاضي الموصل في الإمامة بين يدي السلطان ، فانتهى الأمر إلى المباهلة ، فتباهلا ، وجعلا الكفّ في الكفّ ، ثم القاضي لمّا قام من موضع المباهلة حمّ وانتفح الكفّ الذي»
ومن هذا ما رواه الكشي بسنده عن صفوان ، قال : «دخلت على أبي الحسن الأوّل عليه السلام فقال لي :يا صفوان ، كلّ شيء منك حسن جميل ما خلا شيئاً واحداً
قلت : جُعلت فداك ، أي شيء؟
قال :إكرائك جمالك من هذا الرّجل يعني هارون.
قلت : والله ما أكريته أشراً ولا بطراً ، ولا للصيد ، ولا للهو ، ولكن أكريته لهذا الطريق ـ يعني طريق مكّة ـ ولكن أبعث معه غلماني.
فقال لي :يا صفوان ، أيقع كراك عليهم؟
قلت : نعم ، جُعلت فداك.
قال : فقال لي :أتحبّ بقائهم حتى يخرج كراك؟
قلت : نعم.
قال : فمن أحبّ بقاهم فهو منهم ومن كان منهم كان ورد النار.
قال صفوان : فذهبت وبعت جمالي عن آخرها ، فبلغ ذلك إلى هارون فدعاني فقال لي : يا صفوان ، بلغني أنّك بعت جمالك؟
قلت : نعم.
فقال : ولِمَ؟
قلت : أنا شيخ كبيرٌ وأنّ الغلمان لا يقومون بالأعمال.
فقال : هيهات هيهات ، إني لأعلم من أشار عليك بهذا ، أشار بهذا موسى بن جعفر.
قلت : فما لي ولموسى بن جعفر.
__________________
«مدّه للمباهلة ، ثمّ مات من الغد. منه رحمه الله.
فقال : دع هذا عنك ، فوالله لولا حسن صحبتك لقتلتك؟»(١) .
وهذا الحديث معروف ، وفيه إرشاد إلى مراسم التقوى ومسالك الصلاح ، وبه يتبيّن الرشد من الغيّ وينكشف شدّة أمر ضيق الخلوص.
في دفع ما يتوهّم من كون صفوان بن يحيى جمّالاً
وربّما يتوهّم : كون صفوان بن يحيى جمّالاً أيضاً بملاحظة ما ذكره النجاشي من أنّه حكى أصاحبنا أنّ إنساناً كلّفه [حمل] دينارين إلى أهله إلى الكوفة ، فقال : إنّ جمالي مكراة وأنا أستأذن الاُجراء(٢) .
وهو مدفوع : بأن صفوان بن يحيى لم يكن جمالاً كما صرّح به الشيخ في الفهرست(٣) ، والمقصود بما ذكره النجاشي أنّ صفوان بن يحيى قد اكترى واستأجر جمالاً من الجمّال ولم يكن الجمال من نفسه فلابد من الإستيذان من الجمّال لأنه اكترى جماله ، فلابدّ من الاستيذان ممن اكترى ، كما ينطبق عليه توهم كونه جمالاً ، ويشهد به أن الأجير من يأخذ الأجرة ، فهو المؤجر لا المستأجر.
قال في الصحاح : «الأجر : الثواب والأجرة : الكراء ...»(٤) ، فالأجراء الذين
__________________
(١) اختيار معرفة الرجال : ٤٩٨/٨٢٨.
(٢) رجال النجاشي : ١٩٦ ، ترجمة ٥٢٤.
(٣) فهرست الشيخ : ٢٤١ ، ترجمة ٣٥٦ ، حيث قال : «وقال له بعض جيرانه من أهل الكوفة وهو بمكّة : يا أبا محمّد ، احمل لي إلى المنزل دينارين ، فقال له : إنّ جمالي مكراة حتّى استأمر فيه جمّالي».
(٤) صحاح الجوهري : ٢: ٥٧٦ ، مادّة «أجر» ، والمصنّف هنا اقتصر على مورد الحاجة من عبارته ، وإلّا فعبارته كالتالي : «الأجرُ : الثواب ، تقول : أجَرَهُ اللهُ يأجرُهُ ويأجُرُهُ أجْراً ، وكذلك أجَرَهُ اللهُ إيجاراً ، واُجِراَ فلانٌ خمسةٌ من وَلَدِهِ ، أي ماتوا فصاروا أجْرَهُ ، والأجرَةُ : الكِراءُ ، تقول : استأجرتُ الرجلَ فهو يأجُرُني ثماني حِجَجٍ ، أي يصير أجيري».
وقع عليهم الأجر والعوض ، ويشهد به أيضاً ما ذكره الكشي في نقل الواقعه : من أنّه قال بعض جيرانه من أهل الكوفة وهو بمكّة : يا أبا محمّد إحمل لي إلى المنزل دينارين فقال له : إن جمالي بكراء فقف لي حتى استأمر فيه جمّالي ، فإن المقصود بالجمّال صاحب الجمل ومن يؤجّره لا من يستأجر الجمل.
وربّما توهّم اتحاد مفاد عبارة النجاشي والكشي.
وضعفه ظاهر.
وقد ظهر بما سمعت أن الأجير من الأجرة لا الإجارة.
تذييلان
أحدهما : في أنّه لا حاجة في المقام إلى اعتبار السّند.
أنه لا حاجة في المقام إلى اعتبار السند بناء على التسامح في المندوبات ولا خفاء ، وكذا بناء على عدمه لكفاية الاحتمال في استحباب ارتكاب المندوب بداعي الاحتمال بناء على عدم التسامح في المندوبات ، غاية الأمر أنه لا بد للمجتهد من إعلام ضعف السند بالمقلد ، وأنّه لو أتى بداعي الاحتمال يكون مثاباً كما هو الحال في سائر موارد ورود الخبر الضعيف بالإستحباب بناء على عدم التسامح ، بل لابدّ للمجتهد أن يكون إتيان الفعل منه بداعي الاحتمال.
إلّا أن يقال : إنّ الفعل من المجتهد بعد اطّلاعه على ضعف الخبر بداعي الاحتمال لا محالة.
لكنّه مدفوع : بأن مقتضى كلام بعض أرباب التسامح صيرورة الفعل راجحاً بواسطة أخبار البلوغ.
وبما سمعت تدري أنه لا حاجة إلى الفحص عن السند ، إذ ليس الغرض من الفحص إلّا تشخيص الإعتبار وعدمه فإذا لم يكن حاجة إلى الإعتبار فلا حاجة
إلى الفحص.
لكن إشباع المقال في السند بما تقدم من جهة زيادة البصيرة واستيفاء الكلام في تمام المراحل المتعلقة بالمقام.
ثانيهما : في اختلال حال ما في زاد المعاد وتُحفة الزائر في سند رواية زيارة عاشوراء.
أنه قال العلّامة المجلسي قدس سره في زاد المعاد : «شيخ طوسي وابن قولويه وغير ايشان روايت كرده اند ، از سيف بن عميره وصالح بن عقبه ، وهردو ، از محمّد بن إسماعيل بن بزيع وعلقمة بن محمّد حضرمى ، وهردو ، از مالك جهنى كه حضرت إمام محمّد باقر عليه السلام فرمودند ...»(١) إلى الآخر.
وهذا المقال مشتمل على كمال اختلاف الحال ، حيث إن الشيخ روى عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام فساق بعض أجزاء الحديث كما تقدم إلى أن قال : قال صالح بن عقبة وسيف بن عميرة ، قال علقمة بن محمّد الحضرمي : قلت لأبي جعفر عليه السلام الخ.
ومن الواضح أنه لا ارتباط لما نقله بما نقله الشيخ ، وأما ما نقله عن ابن قولويه فقد تطرق الإشتباه في النقل عنه من وجوه ، حيث إن ابن قولويه قال في كامل الزيارة كما مرّ : حكيم بن داود وغيره ، عن محمّد بن موسى الهمْداني ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة وصالح بن عقبة معاً ، عن علقمة بن محمّد الحضرمي ومحمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن مالك الجهني ، عن أبي
__________________
(١) ترجمة المقطع الفارسي : «روى الشيخ الطوسي وابن قولويه وغيرهما ، عن سيف بن عميرة وصالح بن عقبة ، جميعاً ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع وعلقمة بن محمّد الحضرمي ، عن مالك الجهني ، أنّ الإمام الباقر عليه السلام ، قال : إلى آخره».
جعفر عليه السلام ، وقد أتى بهذا السند في «البحار» ولا خفاء في أنه أسقط في العبارة المذكورة رواية حكيم بن داود وغيره ، عن محمّد بن موسي الهمْداني ، عن محمّد بن خالد الطيالسي من الصدر.
وأيضاً أسقط رواية صالح بن عقبة ، عن مالك الجهني من الذيل ، وأيضاً جعل محمّد بن إسماعيل معطوفاً على علقمة ، مع أنّ رواية محمّد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة تنافي ذلك لأنّ المفروض رواية صالح بن عقبة عن محمّد بن إسماعيل أيضاً فيلزم رواية محمّد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة مع أنّ طبقة صالح بن عقبة مقدمة على طبقة محمّد بن إسماعيل فلا مجال لروايته عنه ؛ إذ المقصود بمحمّد بن إسماعيل هو محمّد بن إسماعيل بن بزيع بشهادة التقييد بابن بزيع في بعض روايات كامل الزيارة ، فضلاً عن شهادة التقييد بابن بزيع في رواية «المصباح» ، مضافاً إلى تصريح النجاشي والكشي والشيخ في الفهرست بأنّ صالح بن عقبة له كتاب يروي عنه محمّد بن إسماعيل بن بزيع.
وقد عدّ الشيخ في الرجال نقلاً محمّد بن إسماعيل بن بزيع من أصحاب مولانا الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام وعدّ صالح بن عقبة من أصحاب مولانا الصادق والكاظم عليهما السلام أيضاً فلا مجال لرواية سيف بن عميرة وصالح بن عقبة عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع مع قطع النظر عن فساد جعل محمّد بن إسماعيل في رواية كامل الزيارة معطوفاً على علقمة.
وربما جعل بعض الأعلام محمّد بن إسماعيل معطوفاً على محمّد بن خالد الطيالسي ، إلّا أنه وإن كان العطف على محمّد بن موسى خالياً عن الواقع ، لكن يمكن أن يكون معطوفاً على حكيم بن داود ، ويرشد إليه رواية الشيخ ، كما مرّ عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة ، ولو فرض عدم مساعدة الطبقة ، تكون الرواية عن الكتاب ، كما هو الحال في رواية الشيخ عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع.
وبما مرّ يظهر حال ما صنعه في تحفة الزائر وهو على منوال حال زاد المعاد ، إلّا أنه لم ينسب إلى أحدٍ قال : «بسند معتبر منقول است از سيف بن عميرة وصالح بن عقبة وهردو از محمّد بن إسماعيل از مالك جهني كه حضرت امام محمّد باقر عليه السلام فرمود»(١) .
في أنّ المدار في «تحفة الزائر» و «زاد المعاد» في باب سند زيارة عاشوراء على النقل عن «كامل الزيارة» وفي باب المتن على النقل عن «المصباح».
ثم إنّه يظهر بما مرّ هنا مع ما تقدم من متابعة العلّامة المجلسي قدس سره في «تحفة الزائر» و «زاد المعاد» لرواية «المصباح» في موارد اختلافها مع رواية «كامل الزيارة» في الغالب وربما وافق «كامل الزيارة» وربما خالف «كامل الزيارة» و «المصباح» أنه جرى في باب السّند على رواية «كامل الزيارة» وفي باب المتن على رواية «المصباح» وهو قد جرى على رواية «كامل الزيارة» في شرح مثوبات الزيارة وغيرها ، والله العالم.
__________________
(١) ترجمه المتن : «نقل بسند معتبر عن سيف بن عميرة وصالح بن عقبة ، جميعاً ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن مالك الجهني : أن الإمام الباقر عليه السلام ، قال : ...».
خاتمة
يا أخي :
أشدد حيازيمك للموت |
فإن الموت لاقيكا(١) |
وهو يأتي بغتة والقبر صندوق العمل ، فلا تكن ممن بدنياه اشتغل قد غرّه طول الأمل(٢) ، وشدّ الوثاق والنطاق لأداء التكاليف الإلهيه فإنها على بعض التفاسير قد عرضت على السموات والأرض فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان أنه كان ظلوماً جهولاً(٣) ، فأيّ بيان بأي بنان(٤) يطيق لتحرير مراحل عسر نوع التكليف ، ومع قطع
__________________
(١) هذا البيت ضمن بيتين مشهورين عن أمير المؤمنين عليه السلام تمثّل بهما ليلة شهادته ، وهما :
اشْدُدْ حَيَازِيمَكَ للموتِ |
فإنَّ الموتَ لاقِيكَا |
|
ولا تَجْزَعْ من الموت |
إذا حَلّ بوادِيكَا |
(٢) وهذا أيضاً إشارة إلى بيتين في الموعظة وذكر الموت ، وهما :
يا من بدنياه اشتغل |
قد غرّه طول الأمل |
|
والموت يأتي بغتة |
والقبر صندوق العمل |
(٣) أشار إلى تفسير قوله تعالى : ( إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ) الأحزاب ٣٣: ٧٢.
(٤) البنان : الأصابع أو أطرافها على ما هو في القاموس ، وهو بالفتح على ما اُعرب في القاموس. منه رحمه الله.
النظر عن التفسير المشار إليه نقول : إنّ مثل نوع التكليف إنما هو الأمر بصيرورة الجبل يتحمل المحنة كالرماد والأمر باستقامة شعلة السراج في يوم عاصف وريح قاصف والأمر يتحمل القطن النار في جوفه ، ولنعم ما قيل بالفارسية :
در ميان هفت دريا تخته بندم ميكني |
باز ﻣﻴﮕﻮئى كه دامن تر مكن هشيار باش |
ويرشدك إلى ذلك ضعف بنيان الإنسان في غاية ما يدخل تحت الإمكان ، كما هو مقتضى قول سيّد السُّجّاد وزين العُبّاد عليه آلاف التحيّة من ربّ العباد :
«اللّهُمَّ وَإِنَّكَ مِنَ الضَّعْفِ خَلَقْتَنا، وَعَلَى الْوَهْنِ بَنَيْتَنا، وَمِنْ ماءٍ مَهينٍ ابْتَدَأْتَنا »(١)
ومثل حاله في عدم التمكّن من حمل ثقل المجاهدة ، ورعاية التكليف جناح الذباب والبعوضة ، وانظر أيها اللبيب إن الإنسان من ضعف عنصره لا يطيق في حال المرض للصيانة والتحفظ عمّا يضره ، فكثيراً ما يقدم على الأكل أو الشرب ممّا يضرّه بل يوجب هلاكه ، بل كثيراً ما يأكل بعض السموم من جهة قليل من الغضب ، فمن طاقته في تحمل خلاف الميل على هذا السياق والمساق كيف يتمكّن من تحمّل الغضب الشديد وترك الشهوات الغليظة طول العمر.
ويرشدك إليه أيضاً : أنّ الله سبحانه جعل بعض أفراد الإنسان فتنة للبعض ، كما نصّ عليه في الكتاب العزيز(٢) ، وشرارة الإنسان(٣) على حسب الميزان في حدّ
__________________
(١) الصحيفة السجّادية : الدعاء ٩ من دعائه عليه السلام في الاشتياق إلى طلب المغفرة من الله جلّ جلاله.
(٢) قوله تعالى : ( وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً ) الفرقان ٢٥ : ٢٠.
(٣) وقد حكي في المجمع عن قائل من خاصّته : «أنّ الإنسان مركّب من صفات»
لا يطيق إحصائها نطاق البيان ، ويظهر ذلك بمعاشرتهم لمن كان معاشرته على وجه الفطانة ، كيف وظالمو سيّد الشهداء روحي وروح العالمين له الفداء بالقتل أو الجرح أو أسر العيان أو نهب الأموال لم يكونوا إلّا من نوع الإنسان ، كما أن إخوة يوسف عليه السلام كانوا من أبناء الأنبياء ، ومع هذا فعلوا فعلتهم التي فعلوا بيوسف مع كمال حسن وجهه الموجب لهلاك النفس له ، فضلاً عن الممانعة عن إيذائه ، ولم يكن إخوة يوسف عليه السلام من غير نوع الإنسان ، وعلى هذا حال سائر ما وقع من الكفّار بالنسبة إلى سائر الأنبياء.
وانظر أيّها اللّبيب ، أنّ جراحات اللّسان شديدة التأثير في روح الإنسان من جهة شدّة اللطافة أو ضعف البنيان ، بحيث كأنها توجب انقطاع الأرواح عن الأبدان ، وهذه الشدّة مع غاية اشتدادها وتطرّقها في عموم الأوان أهون سمومات الإنسان.
ﭘﻴﺶ اين فولاد بى اﺳﭙﺮ ميا |
كز بريد تيغ را نبود حيا |
|
لو خبرتهم جواز اخبري |
لما طلعت مخافة ان تكادا |
فكيف الحال في المعاشرة مع الإنسان في طول الزمان.
وقد سمعت أنّ في زمان الأفاغنة ضيّف شخص أشخاصاً ، فاجمع الأشخاص على أن يُضرَبَ رأسُ المُضيِّفِ من الخلف حال قيامه على وجهٍ موجبٍ للضحك.
فلاحظ كيف جرى الأشخاص في جزاء الضيافة ، وكيف جرؤا على القتل بواسطة شهوة خفيفة أعني الضحك القليل ، وحال الطبيب غالباً على أنه لو عالج بعض الأطباء بمعالجةٍ وأتى بعض آخر للمعالجة فيعالج الثاني بما يضاد معالجة الأوّل ، ولا يبالي بهلاك المريض ولو كان نبيّاً ، كما أنّه يمسك عن المعالجة طلباً لحقّ القدم
__________________
«بهيميّة وصفات سبعيّة وصفات شيطانيّة ، وقد عجنت تلك عجناً محكماً لا يكاد يتخلّص منها». منه رحمه الله.
ولو علم بهلاك المريض لولا المعالجة ولو كان المريض نبيّاً ، بل لو سقطت كلمة من لسانه غفلة فيعالج به ولو هلك المريض ولو كان نبيّاً ، ولا يرضى بصدور الغفلة عنه ، بل الإنسان لا يرضى بالإمساك عن كلمة في مقام حكاية واقعة ولو كانت الكلمة موجبة لهلاك نفسٍ ولم يضرّ الإمساك بحاله بوجه من جهة مجرّد الميل إلى الاستيفاء في نقل الواقعة ، والظاهر بل بلا إشكال أن الله سبحانه أدرج جميع الفتن في قالب الإنسان بواسطة الابتلاء والافتتان وليس الإنسان إلّا كالسّبع الضعيف عنصره المتقلب حاله وخياله كل آن يهوى ، ولنعم ما في المثنوي :
ما همه شيران ولى شير علم |
حمله مان از باد باشد دم بدم |
فمع ما ذكر ما أشقّ رعاية التكليف في المعاشرات ولا محيد للإنسان عن المعاشرة.
ويرشدك إليه أيضاً : أنّ غالب أفراد الإنسان صرف الجنون ، وناهيك في الباب ما في الكتاب من أنّ كثيراً منهم : ( لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ) (١) ، وفي كلام بعضٍ : إنّ عقل أربعين رجلاً يوازن عقل شاة ، ومن نظر في أحوال غالب أفراد الإنسان بعين البصيرة يصدِّق هذا المقال ، فوا شّدتاه ، ثمّ وا شدّتاه من مشقّة رعاية التكليف في المعاشرات.
ويرشدك إليه أيضاً : عداوة الأزواج والأولاد ، كما نصّ عليه في القرآن في قوله سبحانه : ( إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوّاً لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) (٢) بناءً على كون (من) زائدة ، حيث إنّ المقصود
__________________
(١) الأعراف ٧: ١٧٩.
(٢) التغابن ٦٤: ١٤.
بالعدواة في الآية هو العدواة الدنيويّة لا العدواة الاُخرويّة ، أي المانعة عن الاشتغال بما يتعلّق بالآخرة ، ولا سيّما مع قلّة العقل في الأزواج بالنسبة إلى الرجال بعد قلّة عقلهم وكذا اعوجاج السليقة فيهن ، كما هو مقتضى ما في بعض الأخبار من : أنّ إبراهيم خليل الرحمن شكى إلى الله عزّ وجلّ من خُلُقِ سارة ، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه أن مثل المرأة مثل الضّلع إن أقمته انكسر وإن تركته استمتعت بها(١) .
ويرشدك إليه أيضاً : أنّ الله سبحانه قد بالغ في وجوب مراعاة الوالدين حتى نهى عن التأفيف ، والحق دلالته على حرمة ما يساوي التأفيف وما دون التأفيف في الأذيّة بناء على كونه كناية عن حرمة مطلق الأذية من باب التنبيه بالخاص على العام ، كما حرّرناه في الاُصول ، وقال سبحانه : ( أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ) (٢) ، بل ربّما يستفاد من قوله سبحانه : ( رَبَّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ) (٣) بعد أن نهى عن التأفيف وأوجب مراعاة الوالدين التهديد على إضمار الكراهة فإنّه لولا هذا لبعد الاقتران.
وانظر أيّها اللبيب ، أنّ المرأة المسبوقة بالتوصيف ، المحشورة مع الإنسان في اليوم والليل ، أعني الوالدة كيف يعسر الوفاء بخيالاتها ، ولا سيما مع وجود الزوج ، فإنه حينئذٍ تتزايد وتتأكّد شهوات الوالدة ، ولاسيّما مع فوت الوالد ، فإنه حينئذٍ تنصرف حاجاتها إلى الولد وتشتد الشدة ، وقد كان بعضٌ في حداثة السنّ صاحب الحرفة الدنيّة أو المتوسطة ، وكان له قطرة حسنة وتطرق عليه وسعة المعيشة وتأهل ولم يتمكّن من الازدواج مع الوالدة فخرج عن بيته ذبّاً عن المخالفة فكانت والدته تبكي وتضرب رأسها على الأرض وتدعو عليه إلى أن تدانى أمر معيشته ومات في
__________________
(١) فروع الكافي : ٥: ٥١٣ ، باب مداراة الزوجة ، الحديث ٢.
(٢) لقمان ٣١: ١٤.
(٣) الإسراء ١٧: ٢٥.
حداثة سنة ، فانظر أيّها اللبيب كيف يعسر أداء التكليف.
ويرشدك إليه أيضاً : أنّ الله سبحانه قد أوجب صلة الرحم في آيات متعدّدة وبالغ في الباب حيث قال : ( وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ) (١) ، مضافاً إلى تصدير السورة به وتشبيه الأرقاب بالعقارب معروف ، فيا لله في مراعاة التكليف في المعارشة مع أشباه العقارب ، فمع هذا ما أشدّ طول مسافة المجاهدة المحتاج إليها في رعاية التكليف في الإزدواج بالأزواج والأولاد.
ويرشدك إليه أيضاً : تسليط الشيطان على الإنسان كما هو مقتضى قوله سبحانه : ( وَاسْتَفْزِرْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ ) (٢) ، وكذا الأخبار ، وهذه الجهة أشدّ من اخواتها السابقة واللاّحقة في الممانعة عن مراعاة التكاليف بل هي العمدة.
ويرشدك إليه أيضاً : ما جرى عليه الله سبحانه من كون الإنسان في المشقّة ، كما هو مقتضى قوله سبحانه : ( لَا أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ * وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ * لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ) (٣) ، أي المشقّة ، ولا سيّما مع التأكيد الأكيد فيه وتقدير تماطر المحن على صحن دار الدنيا التي أصلها مخلوق من المحنة ، كما هو مقتضى ما في الأخبار من أنه لو وقع الغريق في البحر على جزيرة ، أو أوى شخص إلى رأس جبل يخلق الله سبحانه من يؤذيه ، فمع هذا ما أشدّ المجاهدة المحتاج إليها في رعاية التكاليف.
ويرشدك إليه أيضاً : أنّ السلوك سبيل المجاهدات بعد تيسّره لأندر نادر كثيراً ما
__________________
(١) النساء ٤: ١.
(٢) الإسراء ١٧: ٦٤.
(٣) البلد ٩٠: ١ ـ ٤.
يوجب الانجرار إلى الكفر ، بل الاعتدال ليس إلّا من قبيل خطّ موهوميّ يوجب الموصول إليه التجاوز عنه ، وكلّ ما تجاوز عن حدّه انعكس إلى ضدّه فالأمر دائر بين الإفراط والتفريط ، فمع هذا ما أشدّ اشتداد تحصيل النجاة.
ويرشدك إليه أيضاً : حرمة طائفة من الأمور النفسانية نحو الكبر والحسد والعجب بناء على حرمة تلك الأمور بنفسها لا حرمة إظهار آثارها ، فإن خَلْعَ تلك الأمور عن النّفس والمجاهدة في إزالتها عن القلب في كمال الإشكال ، فما أشكل رعاية التكاليف الشرعية.
ويرشدك إليه أيضاً : أنّ اللّسان سهل الحركة ، وحركته توجب الغِيبَةَ كثيراً ، فما أشقّ المواظبة على ترك الغيبة ، بل من أعظم محن الدنيا أنّه ربّما تكون كلمة تأتي بحركة اللّسان توجب مفاسد كثيرة والمواظبة على صيانة اللسان فيها مشقّة كاملة ، ولا سيّما مع كون حرارة ما يوجب التكلّم بحيث كأنها توجب احتراق القلب ، فانظر أن الإنسان ربّما يرضى بأن يتكلّم بكلمة ولو صارت الكلمة موجبة لقتله ، ولا يعرف ما ذكرناه من لم يضبط لسانه ، وعلى هذا المنوال الحال في سائر المجاهدات فإنه لا يعلم بشدّتها على ما هي عليه من لم يأت بها ، وكذا الحال في المشقّات الدنيويّة فإنّه لا يتفطّن بها على ما هي عليه من لم يتّفق له الابتلاء بها ولو قصّ عليه القصّة ما بلغ بيان.
مَنْ لمْ يَبتْ والحبُّ حشو فؤادِهِ |
لم يَدرِ أينَ تُفَتتُ الأكبادُ |
بل ليس كلمة تخرج على وفق ميل الطبيعة إلّا وهي توجب المفسدة ، فوا شدّتاه ، ثمّ وا شدّتاه من دار هذه حالها ، فهل سجن أضيق وأصعب على النفس من هذه الدار ، فإن المسجون في شيءٍ من السجون لا يمانع عن التكلّم بوفق الميل ، بل الرّوح في البدن ممنوع من أكثر شهواته بل متابعة أكثر الشهوات توجب المفسدة
الدنيويّة ، ولو كانت الشهوة خفيفة فيا لله من هذا الشجن لهذا المسجون.
فنقول : إنّ كلاً ممّا ذكر من المرشدات كافٍ في الباب وإن تضايقت عن كفاية البعض ، فلا ريب في كفاية المجموع فلات حين مناص عن الصبر وأي صبر :
صَبْرٌ بما لو تَحملُ بعضَهُ جبالٌ |
برضوى أصبحتْ تتصدّعُ |
ولنعم ما في الأخبار من أنّه لولا مراعاة الصبر يتطرّق الكفر ، لكن مرارة الصبر في كلّ آن أمرّ من الصبر(١) فيكف الحال بمدّة العمر ، إلّا أنّه لو لم يكن الأمر في غاية العسر والمرارة لما كان للصالحين أن يدخلوا جنات عدن والملائكة يدخلون عليهم من كلّ باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عُقبى الدار(٢) ، فلا حول ولا قوة إلّا بالله ، ولا محيص ولا مخلص عن سؤال التوفيق والتسديد من الله سبحانه.
ولنعم ما يستفاد من بعض فقرات نهج البلاغة من أنّ الإنسان من شدة تغوّره في الشهوات لا يمكنه ولا يتمكن من الانتفاع بنفسه والخروج عن مفاسده ، إلّا بإعانة الله سبحانه وتوفيقه للانتفاع والخروج ، ولعمري إنّ غالب أفراد نوع الإنسان يأتي بالعصيان المناسب لشأنه على وجه العيان ، مثلاً بعضٌ يشرب الخمر بالمجاهرة ولا يأبى عن السياسة ، وهذا أخس درجات الإنسان ، وبعض يأتي بالقضاء جهراً مع عدم القابلية.
فويلٌ ثمَّ ويلٌ ثمَّ ويلٌ |
لقاضِ الأرضِ من قاضِ السماءِ |
__________________
(١) قوله : «من الصبر» قال في القاموس : «الصبر ككتف ، ولا يسكّن إلّا في ضرورة شعر ، عصارة شجر مرّ». منه رحمه الله.
(٢) إشارة لقوله تعالى : ( جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِن آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ * سَلامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ) الرعد ١٣ : ٢٣ و ٢٤.
وبعض يأتي بالإجازة مع عدم القابلية لها لغير القابل ولا يأبى القاضي والمجيّز عما يقع عليهما من سنان اللسان ، فضلاً عمّا يتعقّب في الآخرة من الخسران ، وليس الباعث إلّا حبّ الرياسة وانتشار الاسم ، وهذا حال أعلى درجات نوع الإنسان ، فهل يبقى مجال الصّلاح لأحد ، ولنِعم ما قيل بالفارسية :
خلق همه مستند ولى هركه بصهبائى |
بُلبل خون ﺟﮕﺮ از جائى ﮔﻞ از جائى |
وأيم الله إنّ ورع غالب أفراد الإنسان ، من قبيل ما حكي من أن جماعة كان يزني كل واحد منهم مع امرأة في الخلوة ، فقال أحدهم للمرأة : إني لا أزني وأخبري الرّفقاء بالزناء وأعطاها خمسة دراهم.
فقالت : إني لا أكذب لخمسة دراهم.
وكذا ما حكى من أنّ شخصاً رأى شخصاً يأتي باللّواط في المسجد ، فألقى عليه ماءً من فيه ، فقال الشخص اللاطي : ألم تسمع أنّ إلقاء الماء من الفم في المسجد مكروه.
وكذا ما حكى من أن شخصاً رأى شخصاً يزني في المسجد ، فقال : ما هذا العمل فربّما ينعقد نطفة حرام ويأتي ولد الزناء.
قال : لولا كراهة العزل لما جرئت على الإنزال.
والوجه فيما ذكر أنّ الإنسان غريق بحر التكاليف ، فربّما كانت بعض التكاليف سهلاً أو كانت النفس غير مائلة إليه وكان حسن الفطرة وقوة النفس على مقدار يقتضي امتثاله ، وأما بعض آخر فربّما كان عسراً أو كانت النفس شائقة إليه ، أو كان حسن الفطرة وقوة النفس على مقدار غير وافٍ بامتثاله فيخالف جهراً كما يرتكب شرب الخمر جهراً من يرتكبه بواسطة سوء الفطرة وضعف النفس ، وربّما كان بعض في صورة الورع وهو كان قد كتب مسألة فذاكرتُ معه وسألتُ عنه فلم يتمكن
من الجواب ، فأجاب بأن زيادة تعميق النظر في المسألة لم يكن متعارفاً في أزمنة الحضور ، وحال أكثر الناس في أداء التكاليف حال المفطرين في يوم الصوم من البدو إلى ما قبل الانتهاء بالتدريج.
ومع ما سمعت نقول : إن كثيراً من أفراد الإنسان قد بلغوا مبلغاً عظيماً من التقوى والمجاهدات ورعاية التكاليف وتحمّل شدائد الزّهد فليس الأمر من باب التكليف بما لا يطاق ، بل لا بدّ من شدة السّعي في المجاهدة ولا تتوحّش من شدّة عسر أداء التكليف ، فإنها من باب تكاليف أرباب التربية ، على ما حرّرناه في الاُصول ، وكلّما كانت صفات كمال المربي أزيد وأعلى كانت تربيته أشقّ ، فكيف لا يكون أداء التكاليف الإلهية في غاية المشقة مع عدم تناهي صفات كماله وبلوغ كلّ من صفات كماله حدّ الكمال مضافاً إلى أنّ التكاليف الإلهيّة على حسب المصالح والمفاسد الواقعية وحال المصالح والمفاسد الواقعيّة في اقتضاء الأمر والنهي غير مربوطة بجعل الشارع وتعسيره.
وبعد ذلك أوصيك بتقوى الله سبحانه والتفرغ إليه ، وهو حسبك ونعم الوكيل والكفيل ، ولا يذعن بمواظبته سبحانه على التأثير في القضايا الشخصيّة من باب مجازاة الأعمال من لم يحصل له التجارب ، فتجارب حتى يزيد في تقواك وتفرغك إليه سبحانه.
وأوصيك أيها الطالب للعلم والتقوى بتصفية الأخلاق ، وتخلية الطبيعة عن الرّذائل ، وحسن المعاشرة ، فإنّه لولا ما ذكر لما أثمر العلم والتقوى إلّا مهانة وسفاهة في الدنيا وخسراناً في الآخرة ، وحسن المعاشرة أمر دقيق في غاية الدقة ، ولم يدوّن له علم ، بل لا يمكن تدوينه في علم لابتناء الأمر على خصوصيات الموارد والكافل تصرّف الطبيعة. نعم ، علم الأخلاق والأخبار يكفل كثيراً من مراحله.
ثمّ إنّ معاشر الأخوان والخلان قد بذلتُ الجدّ والجهد ، وكابدتُ الكبدَ في هذه
الرسالة ، بحيث لا يستطيع جوادٌ(١) بعد غايته ، ولا يطير طير إلى نهايته ، خدمةً لملاذ الخافقين ، وشفيع الثقلين ، مولاي ومولى الكونين روُحي وأرواح العالمين له الفداء ، ولعن الله أمة قتلته أو ظلمته أو سمعت بذلك ورضيت به ، وأرجو منه الشفاعة في يوم الجزاء.
وقد طال الاشتغال بتلك الرسالة إلى سنتين تقريباً ، بل تحقيقاً ، وقد كتبت طريقة الاحتياط خمس عشر مرّة من باب تجديد النظر وإصلاح ما فسد ، هذه اُصول المرات وإلّا ففي كلّ مرة لعلّه جاء مرّات.
ولقد جريتُ في كل ما جرى عليه قلمي إلّا أقلّ قليل على غاية من التعب والنصب ، وربما طالت مدّة الفكر في صفحة أو صفحتين إلى شهر أو شهرين ، وربّما امتدّت مدّة الفكر في بعض المطالب إلى شهرين أو أربعة أشهر ، وربّما كنتُ في التفكّر في عبارة لكن لا على وجه الاستغراق متمادياً إلى ستّة أشهر ، وا شدّتاه من حرارة الفكر وحالاته يخترق القلب بحراراته.
مَنْ لمَ يَبِتْ والحُبّ حشوَ فؤادِهِ |
لم يدرِ كيفَ تُفتتُ الأكبادُ |
وليس شيء من ذلك إلاّ من عناية الله سبحانه جلّ وعلا ، قال الله سبحانه :
(
وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِن أَحَدٍ أَبَداً وَلكِنَّ اللهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ
)
(٢)
، وقد صبرتُ في محنِ هذه الدار دار النار ومنها محنة الفكر وتعميق النظر بعد محن أصل التحصيل (على طخيات(٣)
عمياء ، يشيب فيها الصغير ، ويهرم فيها الكبير ، ويكدح فيها مؤمن ، حتّى يلقى ربّه ، وفي العين قذى ، وفي الحلق
__________________
(١) قوله : «بحيث لا يستطيع جواد بعد غايته» هذا مأخوذ من بعض أشعار الفرزدق في مدح مولانا سيّد السجّاد وزين العباد عليه آلاف التيّة من ربّ العباد إلى يوم التناد. منه عفي عنه.
(٢) النور ٢٤: ٢١.
(٣) قوله : «طخيات عمياء» مأخوذة من الخطبة الشقشقيّة. منه عفي عنه.
شجى)(١) ، ولعلّه لم يتّفق ما اتّفق عليّ من الصبر على المرارات لأحدٍ بعدَ العصمة ، وليس الصبر إلاّ من عناية الله سبحانه ، قال الله سبحانه خطاباً للنبيّ صلى الله عليه وآله : ( وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ ) (٢) ، وكان كثرة اشتغالي بحيث كنتُ استصحبُ أسباب الكتابة في الحمام ، وكتبتُ فيه فصلاً عن صرف الزّمان فيه في الفكر غالباً ، بل كنتُ متشاغلاً بالفكر في المشي حتى في الليالي ، وكذا في المكالمة الغير معي ، بل كنتُ كلّما تيقظتُ من النوم أتوجه إلى الفكر بمجرّد التيقّظ ، بل كنتُ كلّما انقلبتُ في النوم من شقّ إلى شقّ أتوجه إلى الفكر وكنتُ في بعض السنوات في أيام الشتاء صائماً من جهة اختلال المعيشة بملاحظة قوله سبحانه : ( وَاسْتَعِينُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ) (٣) ، لتفسير الصبر بالصوم وكنت أصلّي صلاة العشائين بوضوء صلاة الفجر مع الاشتغال من الصباح إلى الرّواح ، وقد انجرّ الأمر إلى ضعف القلب ، ثمّ بعدَ البُرءِ في الجملة عدّتُ إلى السيرة الاُولى ، ثمّ عاد ضعف القلب ، ثمّ بعدَ البرءِ في الجملة قد اكثرتُ الاشتغال أيضاً بحيث ما أفطرت في شهر الصيام في سنتين إلّا بعد كتابة ما ألزمتُ على نفسي أن أكتبه كلّ يوم ، ثمّ انجرّ الأمر إلى جفاف المعدة من زيادة السهر ، وكان الأمر بحيث لو خليت المعدة توجع الودجات وعسر التكلّم وذلك باق إلى الحال ، وقد مضى عليّ سنوات بتلك الوتيرة ، ولله الحمد ، وله الشكر فوق ما يحمده الحامدون ويشكره الشاكرون على عنايته بالتوفيق.
«إلهي إِنْ لَمْ تَبْتَدِئْني الرَّحْمَةُ مِنْكَ بِحُسْنِ التَّوْفِيقِ فَمَنِ السَّالِكُ بي إِلَيْكَ في وَاضِحِ الطَّرِيقِ؟ »(٤) وقد وصل من جانب الله سبحانه جلّ وعلا عنايات دنيويّة بحيث
__________________
(١) هذا تمثّل بكلام أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين عليه السلام في خطبته الشقشقيّة.
(٢) النور ٢٤: ٢١.
(٣) البقرة ٢: ٤٥.
(٤) مقطع من دعاء الصباح.
لم يمكن أن يتفق وقوعه بحسب المعتاد ولم يمكن وقوعه إلّا من جانب الله سبحانه ، وقد تفألتُ من القرآن بعد أن أصبتُ بموتِ الوالدِ الماجدِ وكنتُ حين موته غير بالغ حدّ البلوغ استعلاماً لما يصير إليه أمري فجاء : ( وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ) (١) ورأتْ زوجةُ الوالد الماجد ـ غير الوالدة ـ في النوم مقارناً لتولدي أنّه جاء شخص بطفل من جانب السماء وقيل : هذا لوالدتي ، فذهبتْ إلى الوالد الماجد قدس سره وقالتْ : وضعتْ الزوجة الحاملة حملها لمّا رأت في حال النوم ، والوالد الماجد قد حكى أصل هذا النوم في صغر سنّي.
وقال بعض الثقات : إنّه رأى في النوم في أزمنة تولدي ـ سابقاً عليه أو لاحقاً له ـ أنه أتى شخص بطفل إلى الوالد الماجد قدس سره وهو قد أرضعه ثم نقله للوالد الماجد قدس سره فقال الوالد الماجد قدس سره : إنّه يتولّد لي ولد يتحمّل زحماتي.
ورأى بعض الطلاب في أزمنة تحصيلي أني صرتُ كوكب المريخ وارتفعتُ إلى السماء.
ورأت زوجتي قبيل التزويج أنه سقطَ القمرُ وتوجه إليها ، وقد كتب الوالد الماجد قدس سره عند كتابة تاريخ تولدي أني أودعته عند الله سبحانه فإنّه لم يبق من عمري شيء جدّا ، والظاهر أنّ توديعه لي عند الله سبحانه كان موجباً لعناية الله سبحانه ومَنّه بجوده وكرمه عليّ بحسن التوفيق ، فضلاً عن أن الظاهر أنّ ما وقع منه من الخدمة بالشريعة المقدسة المطهّرة لم يتفق لأحد ممن سبق عليه في زمان الغيبة ، حيث إن مقتضى الكتاب والسنة أنّ الله سبحانه يتفضّل على الأولاد بتوسّط الأعمال الصالحة الصادرة من الآباء فإن مقتضى قوله سبحانه حكاية عن خضر في باب إصلاح جدار غلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما حيث أقامهُ بعد أن أراد
__________________
(١) طه ٢٠: ١٣.
أن ينقض ( وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ ) (١) من باب دلالة التنبيه كون صلاح الأب علّة في إصلاح الجدار ، قضيّة أن أراد الله سبحانه أن يستخرج الغلامان كنزهما بعد أن يبلغا أشدهما رحمة منه سبحانه لهما
ونقل البيضاوي أنه قيل إن الفاصلة بين الغلامين والأب كانت سبعمائة سنة.
وفي بعض الأخبار أنّ الله سبحانه بصلاح المؤمن يصلح أولاده وأولاد أولاده وأهل بيته وأهل البيوت في حواليه ، وإلّا فإني كنتُ فاقد لمقتضي التحصيل مع وجود المانع بل الموانع ، وعلى ذلك جرى حال الوالد الماجد قدس سره فإنه كان ينقل أن والده استغاث إلى الله سبحانه في مرض موته لأجله وأودعه الله سبحانه ، وكان والده مع فضله وتموّله يشتغل بنفسه لأعمال البناء والعملة في تعمير بعض المدارس ، كما أنّ والدته كانت تقضي الصّلاة في المطبخ إلى أن يغلى القدر ويحتاج إلى المواظبة ، والوالد الماجد قدس سره قد بلغ في السموّ والعلوّ المعارج والنهاية والمنتهى ، كأن السماك الرامح(٢) أعزل لدى عزته والنسر الطائر(٣) واقعاً دون رفعته (جرّ مقام الرفع(٤) بالاضافة إذ نودى بالرفع مثل المفرد العلم وقدره القدر ولذا ليس
__________________
(١) الكهف ١٨: ٨٢.
(٢) اسم كوكب من الكواكب الطالعة شمالاً ، وفي قباله السماك الأعزل من الكواكب الطالعة جنوباً.
(٣) وهو أيضاً اسم كوكب من الكواكب الطالعة شمالاً ، وهو أوّل الكواكب ، وفي قباله النسر الواقع.
(٤) قوله : «جر مقام الرفع» هذا إلى اخراه مأخوذ من أشعار البردة في مدح سيّد الأنبياء صلى الله عليه وآله روحي وروح العالمين له الفداء مع التصرّف في الأوّليّين لا سيّما ثانيهما بوجه حسن ، والغرض من جرّ مقام الرفع إنّما هو القهر على مقام الارتفاع والاستيلاء عليه ، فسمّى المرجع إلى كونه في غاية الارتفاع والعزّة ، والأمر من باب التجوّز في الجر»
له بمعرب من معرب أو معجم كأنه وهو فرد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم) ، ومع ذلك كان مقروناً بملائمات الطبيعة خلاف ما انعقدت عليه هذه الدّنيا الدنيّة بحيث لم يتفق مثل ذلك لأرباب السلطنة فضلاً عن العلماء من الخاصة والعامة ، قد جمع له بعناية الله سبحانه بين الدنيا والآخرة وآتاه الله سبحانه في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
أمسى دليل الهدى في الأرض منتشراً |
وفي السماء جليل الحال معروفاً(١) |
وقد قل غاية القلة اجتماع الدارين لأحد في هذه النشاة ، كما هو مقتضى بعض الأخبار الواردة عن أهل بيت العصمة عليهم آلاف السّلام والتحية ويقضي بذلك العيان والمشاهدة ، والغالب إنما هو الدنيا المفردة أو الآخرة المنفردة ، قد تقاضى بعض سلاطين عصره أن يرد عليه وهو قد تضايق منه ، وقال لي مع صغر سنّي في بعض خلواته : من يتمكن من مثل ذلك بعدي ، وربّما كتب بعض حكّام البلد إلى بعض آخر من سلاطين عصره أنه يدعى السلطنة فسافر السلطان إلى أصفهان قصداً للتشدّد عليه وربّما كتب بعض الأمراء إلى بعض تلاميذه أنه لو لم يستقبل السلطان فيرسل شخصاً إلى استقباله أو يخرج عن البلد حتّى يدخل السلطان في البلد فلما وصل الكتاب إليه فقال قبل قراءة المكتوب : إني أعلم ما كتب ، ومنع كلّ من يتعلق به عن الإستقبال وقال : إني لا أضائق عن الخروج عن البلد لكن بعد إياب ذلك يعني السلطان ليعلم أنه لا شأن له ، ثم اقتضى السلطان أن يجئ إلى موضع بين منزله
__________________
«النحوي باستعماله في التخطيط بعلاقة المشابهة ، والمقصود بالرفع هو المعنى اللغوي ، لكنّه لا يخفى ما في ذكر الرفع في قبال الجر من اللطافة. منه رحمه الله.
والبردة قصيدة مشهورة في مدح النبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله للشاعر المعروف البوصيري (المتوفّى سنة ٦٩٤ هـ).
(١) قوله : «أمس ...» مأخوذ من بعض الأشعار المنسوبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام.
ومنزل الوالد الماجد قدس سره وبه خُتِمَ الأمر بعد مجئ غير واحد من علماء العصر ليذهب الوالد الماجد قدس سره إلى الموضع المذكور والعمدة في أسباب عز الوالد الماجد قدس سره إنما كانت هي الإشتهار والإنتشار في سرعة إجابة دعائه على الأشرار والفجّار بحيث لم يعهد مثلها في هذه الشريعة ولا في سائر الشرائع والنتائج تابعة للمقدّمات لكن لو كان النتيجة تابعة للمقدمة في باب عزّه لزم انعدام مثل عزه وربما دعى على بعض أعيان البلد بعد صلاة الظهرين وهو لم يخرج عما دخل فيه للمنام ثم ورد عليه بعض السّادة والأكبر من العلماء وقال : اعتقادي أنه زهقت روحه يعني المدعوّ عليه مقارناً للدعاء عليه وصار ذلك موجباً للاستيحاش منه غاية الوحشة ، وربما نقل أنه كان شخص من الطلاب يتحمل بعض زحماته المتعلقة بالعلم ثم سافر إلى الزيارة ، وهذا كان خلاف ميل الوالد الماجد قدس سره ثم مات ذلك الشخص ثم أقام الوالد الماجد قدس سره شخصاً آخر مقام ذلك الشخص ثم أراد الشخص الثاني أن يسافر إلى الزيارة وكان هذا أيضاً خلاف ميل الوالد الماجد قدس سره.
فقال الوالد الماجد قدس سر : لذلك أعني الشخص الثاني أوصل دعائنا إلى فلان ، وكان غرضه الإخبار بموت الشخص الثاني فسافر الشخص الثاني إلى الزيارة ومات.
ونظيره أنه نقل بعض العلماء أنّ الوالد الماجد قدس سره قال له في بعض الأيام في الحمّام في حق بعض الحكّام وهو كان يريد المسافرة مع العود : اكتب أخبرني مخبر صادق أنّه لا يعود. ولم يعد ولم يكن في البين أثر عدم المعاودة.
[مؤلّفات المصنّف بحسب نقله]
أـ وبالجملة قد كتبت في الاُصول :
١ ـ (البشارات) ، والظاهر أنّه يتجاوز عن مائة وعشرين ألف بيت ، مع قطع النظر عما كتبت في الحواشي كثيراً.
٢ ـ (رسالة في حجّيّة الظنّ) والظاهر أنّها تبلغ ثلاثين ألف بيت ، وحررت فيما خمس وعشرين مقدمة وعشر تنبيهات وحررت في بعض المقدمات وجوهاً في تحرير محل النزاع ولم يتفق تحرير محل النزاع من أحد ممّن حرّر تلك المسألة والتحرير المذكور إنما كان وظيفة أرباب القول بحجيّة مطلق الظن لخفاء مقالتهم ومن أجل خفائها وعدم التفطن بها المصير إلى القول بحجيّة الظنون الخاصة من أربابها وقد أحييت في تلك الرسالة طريقة حجيّة مُطلق الظنّ ، ولا أحسب أن يطّلع من له أدنى ذكاء على ما حرّرت فيها في حجيّة مطلق الظنّ وينحرف عنه ، ومن التنبيهات الكلام في حجيّة الظنّ اللفظي ، وقد حرّرت فيه من باب التنبيه قريباً من ثلاثين عنواناً ومن العناوين الكلام في حجيّة الظن الشخصي والظنّ النوعي في باب الحقائق وحررت فيه خمس وعشرين تنبيهاً ومن هذا التنبيهات الكلام في تفسير الراوي في قرب من ثلاثين عنواناً وحررت في بعض تنبيهات أصل المسألة الكلام في الصدق والكذب متجاوزاً عن عشرين عنواناً.
٣ ـ (ورسالة مختصرة في حجيّة المظنة) وفيها الكفاية والمقنع والمقنعة.
٤ ـ (ورسالة في الشك في الجزئية والشرطية والمانعية) تجاوز المقدمات فيها عن العشرين وكذا تجاوز التنبيهات فيها عنه ، سلكت فيها في أصل المسألة طريقة عذراء ، ولم يتفق مثلها مع أنّ المسألة في غاية العسر في مسألة من المسائل من أحد من الأصحاب فضلاً عن تلك المسألة.
٥ ـ (ورسالة في الفرق بين الشك في التكليف والشكّ في المكلّف به) : وقد بذلت فيها غاية الجهد في التتبع والفكر ، مع أنّ المسألة غير معنونة.
٧ ـ (ورسالة في بقاء الموضوع في الإستصحاب).
٨ ـ (ورسالة في تعارض الإستصحابين).
٩ ـ (ورسالة في تعارض الإستصحاب وأصالة صحة العقد).
١٠ ـ (ورسالة في تعارض الإستصحاب واليد).
١١ ـ (ورسالة في البقاء على تقليد المجتهد الميّت).
ب ـ وكتبت في الرجال رسائل :
١٢ ـ (رسالة في ثقة).
١٣ ـ (ورسالة في أصحاب الإجماع).
١٤ ـ (ورسالة في نقد الطريق) : وهي تشتمل على سبعة وتسعين تنبيهاً ، ولم يتفق مثلها في فنّ من الفنون.
١٥ ـ (ورسالة في تصحيح الغير).
١٦ ـ (ورسالة في النجاشي).
١٧ ـ (ورسالة في محمّد بن الحسن المبدوء به بعض أسانيد الكافي).
١٨ ـ (ورسالة في أبي داود المبدوء به بعض أسانيد الكافي).
١٩ ـ (ورسالة في الحسين بن محمّد المبدوء به بعض أسانيد الكافي).
٢٠ ـ (ورسالة في محمّد بن عبد الله المبدوء به بعض أسانيد الكافي).
٢١ ـ (ورسالة في علي بن محمّد المبدوء به بعض أسانيد الكافي).
٢٢ ـ (ورسالة في الحسين بن محمّد المبودء به بعض أسانيد الكافي).
٢٣ ـ (ورسالة في محمّد بن أبي عبد الله المبدوء به بعض أسانيد الكافي).
٢٤ ـ (ورسالة في علي بن محمّد المبودء به بعض أسانيد الكافي).
٢٥ ـ (ورسالة في محمّد بن زياد).
٢٦ ـ (ورسالة في معاوية بن شريح).
٢٧ ـ (ورسالة في حماد بن عثمان).
٢٨ ـ (ورسالة في محمّد بن الفضيل).
٢٩ ـ (ورسالة في محمّد بن سنان).
٣٠ ـ (ورسالة في علي بن الحكم).
٣١ ـ (ورسالة في أبي بكر الحضرمي).
٣٢ ـ (ورسالة في محمّد بن قيس).
٣٣ ـ (ورسالة في تزكية أهل الرجال).
٣٤ ـ (ورسالة في تفسير العسكري عليه السلام).
٣٥ ـ (ورسالة في علي بن السندي).
٣٦ ـ (ورسالة في حفص بن غياث وسليمان بن داود وقاسم بن محمّد).
٣٧ ـ (ورسالة في روايات ابن أبي عمير).
٣٨ ـ (ورسالة في أحوال شيخنا البهائي).
٣٩ ـ (ورسالة في أحوال الفاضل الخوانساري).
ﺟ ـ وكتبت في الفقه :
٤٠ ـ (مباحث من الوضوء في شرح الكفاية) : ونظمت تلك المباحث بالانفراد
٤١ ـ (ورسالة في أنّ النية هي الإخطار أو الداعي) : وذكرت فيها أنّ نسبة الخلاف المعروف في كلمات الأواخر إلى سابقي الأصحاب لا أصل لها.
٤٢ ـ (ورسالة في أنّ وجوب الطهارات نفسي أو غيري) : ولم يتفق عُشره في كلمات الفقهاء ، وهي مما امتاز في الرسائل المعدودة.
٤٣ ـ (ورسالة في الصلاة في الماهوت).
٤٤ ـ (ورسالة في الصلاة في الحمام الوقف الذي يتصرف فيه غير الأهل).
٤٥ ـ (ورسالة في أفساد الغليان للصّوم).
٤٦ ـ (ورسالة في اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الحجّ).
٤٧ ـ (ورسالة في استيجار العبادة).
٤٨ ـ (ورسالة في الشرط في ضمن العقد).
٤٩ ـ (ورسالة في المعاطاة).
٥٠ ـ (ورسالة في الإسراف).
٥١ ـ (ورسالة في أصوات النساء).
٥٢ ـ (ورسالة في التداوي بالمسكر).
د ـ [متفرّقات] :
٥٣ ـ وكتبت (شرحاً على الخطبة الشقشقيّة).
٥٤ ـ (ورسالة في الإستخارة من القرآن المجيد).
٥٥ ـ (ورسالة في التربة).
٥٦ ـ (ورسالة في سند الصحيفة الكاملة الشريفة السجادية) لمنشيئها آلاف السلام والتحية إلى ساعة القيام وقيام الساعة.
٥٧ ـ (ورسالة في الجبر والتفويض).
٥٨ ـ (ورسالة في شبهة الإستلزام ، والشبهة الحمارية ، والشبهة في حمل المشكوك فيه على الغالب).
٥٩ ـ (ورسالة في الجهة التقييديّة والتعليلية).
٦٠ ـ (وكتبت أجزاء في التفسير).
٦١ ـ (وكتبت حواشي كثيرة على القرآن المجيد) من سورة النساء إلى سورة المعارج.
٦٢ ـ (وكتبت مجموعة) تقرب ثلاثين ألف بيت.
٦٣ ـ (وكتبت خطباً مؤلفة من آيات القرآن).
٦٤ ـ (وكتبت مجموعة في أشعار جيّدة عربيّة) تقرب ألف بيت بل تزيد عليه.
٦٥ ـ (وكتبت رسالة فارسية في أحوال الإنسان).
٦٦ ـ (وكتبت مختصراً في الحساب في حداثة السنّ).
ومن عنايات الله سبحانه جُلّ وعلا على العاثر بأنواع العثار عنايته سبحانه على عمدة التجّار وأرباب اليسار بن الحاج محمّد إسماعيل الحاج عبد الغفّار آتاه الله(١) سبحانه كتابه باليمين والخلد في الجنان باليسار بتوفيقه لطبع هذه الرسالة ورسالة التربة على المنشأ لهما آلاف السلام والتحيّة هنيئاً مريئاً(٢) ووالده عليهما ملابس من أنواع التّاج والحُلي
واللهُ يقضي بهباتٍ وافرةٍ |
لي ولهُ في درجاتِ الآخرةِ |
والله العالم(٣) .
_________________
(١) قوله : «آتاه الله سبحانه» هذا مأخوذ من دعاء غسل اليد اليمنى في الوضوء ، وقد فسّر شيخنا البهائي في الأربعين الخلد في الجنان باليسار ، وما أثبته أوجه. منه عفي عنه.
(٢) قوله : «هنيئاً مريئاً» مأخوذ من أشعار الشاطبي. منه عفي عنه.
(٣) كان الفراغ في السادس والعشرين من شهر صفر المظفّر سنة ستّ وتسعين ومأتين بعد الألف. منه عفي عنه.
قد فرغ ابن محمّد إبراهيم أبو المعالي الشريف في العشر السادس من الثّلث الثالث من الثلث الثاني من الرّبع الأوّل من العشر السّادس من العشر العاشر من العشر الثالث من الألف الثاني(١) .
_________________
(١) ٢٦/٢/١٢٩٦ ﻫﺠ
المحتويات
مقدّمة ٩
نبذه مختصرة ١٥
في حياة المصنّف(١) ١٥
شرح زيارة عاشوراء ٢٥
تمهيد مقدمة لشرح كلام العلّامة المجلسي قدس سره في «البحار» ٥٣
الإيراد على كلام العلّامة المشار إليه في «البحار» بوجوه ٦١
تنبيهات ٩٣
فيما ذكره العلّامة المجلسي قدِّس سرُّه في الاحتياط في زيارة عاشوراء ٩٣
فيما ذكره العلّامة المجلسي قدس سره في زاد المعاد ١٢٢
في أن مقتضى كلام العلّامة المجلسي قدس سره في «تحفة الزائر» ١٢٣
في أن مقتضى كلام السيّد الداماد لزوم إتمام زيارة عاشوراء ١٢٧
في أن زيارة عاشوراء تختصّ بالبعيد أو تعمّ القريب؟ ١٣٨
في أنه هل يشترط في زيارة عاشوراء من البعيد بالبروز ١٤١
أحدها : في أنّه لو كان سطوح الدار مختلفة فكان بعضها فوق بعض ، ١٤٤
في أنّه هل يشترط زيارة عاشوراء بالغُسل؟ ١٥٣
في أنه هل يجوز الإكتفاء في زيارة عاشوراء ١٦٠
في أنه هل يجوز الإتيان بزيارة عاشوراء في مجالس متعددة ١٦١
في أنه هل يجوز كون السّلام الطويل ١٦٨
في أنّ التكلّم في خلال زيارة عاشوراء هل يوجب فسادها؟ ١٦٩
فيما تعارف من الإشارة بالإصبع ١٧٠
أحدهما : في أنّ الإشارة بالإصبع بناء على اعتبارها في الزيارة هل تختصّ ١٧٣
في خروج الصلاة عن الزيارة ١٨١
في خروج دعاء الوداع عن الزيارة ١٨٥
في أنّه إذا كان للزائر حاجة فليسأل الله سبحانه قضائها ١٨٧
في أنّه لا فرق في استحباب زيارة عاشوراء ١٨٨
في استبعاد العقل ترتّب المثوبات الموعودة ١٨٩
في استحباب زيارة عاشوراء في غير يوم عاشوراء ١٩٦
[التذييل الثاني] ثانيهما : في استحباب زيارة عاشوراء في جميع أجزاء ٢٠٨
في اختلاف رواية «كامل الزيارة» و «المصباح» ٢١٠
في شرح طائفة تحتاج إلى الشرح ٢١٨
في تفسير عدّة من خواص النبيّ صلى الله عليه وآله من حرمة خائنة الأعين ٢٣٠
في جواز النيابة في زيارة عاشوراء ٢٣٤
فيما روي من سوانح يوم عاشوراء ٢٣٦
في منام يدلّ على فضيلة زيارة عاشوراء ٢٣٨
في قصّة وقضيّة(١) ٢٤٠
في حال رواية سند زيارة عاشوراء ودعاء الوداع ٢٤٢
خاتمة ٢٦٧
المحتويات ٢٨٩